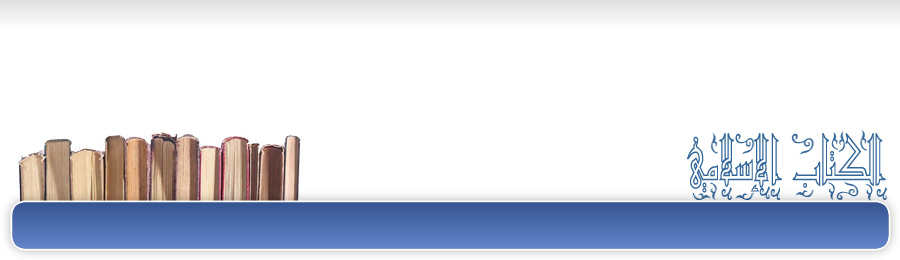كتاب : المعتمد في أصول الفقه
المؤلف : محمد بن علي بن الطيب البصري
المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ الجليل الامام أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري رحمه الله
أحمده على آلائه وأشكره على نعمائه وأستعين به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وسلم
ثم الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب في أصول الفقه بعد شرحي كتاب العمد واستقصاء القول فيه أني سلكت في الشرح مسلك الكتاب في ترتيب أبوابه وتكرار كثير من مسائله وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام نحو القول في أقسام العلوم وحد الضروري منها والمكتسب وتولد النظر العلم ونفي توليده النظر إلى غير ذلك فطال الكتاب بذلك وبذكر ألفاظ العمد على وجهها وتأويل كثير منها فأحببت أن أؤلف كتابا مرتبة ابوابه غير مكررة وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز خلطه بهذا العلم وإن يعلق به من وجه بعيد فإنه إذا لم يجز أن يذكر في كتب الفقه التوحيد والعدل وأصول الفقه مع كون الفقه مبنيا على ذلك مع شدة اتصاله به فبأن لا يجوز ذكر هذه الأبواب في أصول الفقه على بعد تعلقها بها ومع أنه لا يقف عليها فهم الغرض بالكتاب أولى وأيضا فإن القارىء لهذه الأبواب في أصول الفقه إن كان عارفا بالكلام فقد عرفها على أتم استقصاء وليس يستفيد من هذه الأبواب شيئا وإن كان غير عارف بالكلام صعب عليه فهمها وإن شرحت له فيعظم ضجره وملله إذ كان قد صرف عنايته وشغل زمانه بما يصعب عليه فهمه وليس بمدرك منه غرضه فكان الأولى حذف هذه الأبواب من أصول الفقه
فحذاني إلى تأليف هذا الكتاب ما ذكرته وأن يقدم هذا الكتاب أيضا زيادات لا توجد في الشرح وأنا إن شاء الله أذكر الغرض بهذا الكتاب ثم أذكر أقسامه وعدد أبوابه وترتيبها ثم أشرع في الكلام فيها بمعونة الله وحسن توفيقه
باب ذكر الغرض من هذا الكتاب
أعلم أن الغرض بهذا هو النظر في أصول الفقه فإن قيل قولكم أصول الفقه يشتمل على الأصول وعلى الفقه فما الفقه وما الأصول ثم ما أصول الفقه فيل أما قولنا فقه فإنه يستعمل في اللغة وفي عرف الفقهاء أما في اللغة فهو المعرفة بقصد المتكلم يقول فقهت كلامك أي عرفت قصدك به وأما في عرف الفقهاء فهو جملة من العلوم بأحكام شرعية فإن قيل فما الأحكام ها هنا قيل هي المنقسمة إلى كون الفعل حسنا مباحا ومندوبا إليه وواجبا وقبيحا محرما محظورا ومكروها وليست الأحكام هي الأفعال لأن الأحكام مضافة إلى الأفعال لقول أحكام الأفعال والشيء لا يضاف إلى نفسه فإن قيل ما الحسن وما المندوب إليه والواجب والمحرم والمحظور والقبيح والمكروه لأنكم إن لم تبينوا ذلك لم تكونوا قد بينتم الأحكام فلا تكونوا قد بينتم الفقه ولا يمكن أيضا أن تستدلوا على ان الأمر على الوجوب أو الندب إلا بعد أن تعقلوا ذلك قيل له أما الحسن فهو فعل إذا فعله القادر عليه لم يستحق الذم على وجه وأما المندوب إليه في عرف الفقهاء فهو فعل بعث المكلف من غير إيجاب وإذا أطلق أفاد لأن الله عز و جل ندب إليه وأما الواجب فهو فعل للإخلال به مدخل في استحقاق الذم أو للإخلال به تأثير في استحقاق الذم وأما القبيح فهو فعل له تأثير في استحقاق الذم واما المحرم والمحظور فهو ما منع من فعله بالزجر وإذا أطلق أفاد أن الله سبحانه حرمه وحظره ولك أن تقول إنه ما حرم فعله وحظر ومعنى تحريم الله إياه وحظره أنه دل المكلف على قبحه أو أعلمه ذلك واما المكروه في عرف الفقهاء ما الأولى أن لا يفعل وسيجيء شرح ذلك في موضع آخر وإنما ذكرنا من الآن ما تمس الحاجة إليه فإن قيل فما معنى قولكم في الأحكام إنها شرعية قيل معنى ذلك أنها مستفادة إما بنقل الشريعة لها عن حكم الأصل وإما بامساك الشريعة عن نقلها عن حكم الأصل وهذا الأخير إنما يتم لنا بأن يعرف الحظر والاباحة في الأصل ويعرف إمساك الشريعة عن نقلهما وذلك يقتضي أن يذكر الحظر والاباحة في طرق الفقه لأنه لا بد منهما وإن شرطنا فيهما إمساك الشريعة عن نقلهما
فأما قولنا أصول فإنه يفيد في اللغة ما يبتني عليه غيره ويتفرع عليه وأما قولنا أصول الفقه فإنه يفيد على موجب اللغة ما يتفرع عليه الفقه كالتوحيد والعدل وأدلة الفقه ويفيد في عرف الفقهاء النظر في طرق الفقه على طريق الاجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع كيفية الاستدلال بها فإن قيل ولم قلتم إنه يفيد في عرفهم ما ذكرتموه فقط دون غيره مما ينبني عليه الفقه قيل أما أنه يفيد في عرفهم ما ذكرناه من الطرق المجملة وكيفية الاستدلال بها فلا شك فيه وأما أنه لا يفيد غيره مما يبتني الفقه عليه فلأنهم لا يسمون غيره أصولا للفقه وإن يفرع عليه كالتوحيد والعدل والنبوات وأدلة الفقه المفصلة ألا ترى أنهم لا يسمون الكتب المصنفة في هذه الأدلة كتبا في أصول الفقه فإن قيل فما طرق الفقه قيل هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى الفقه فإن قيل وإلى كم ينقسم قيل إلى قسمين دلالة وأمارة والدلالة هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى العلم والإمارة هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى غالب الظن فإن قيل بينوا ما العلم وما الظن الصحيح كما بينتم ما الدلالة وما الأمارة لأن جميع ذلك قد دخل في تفسير طرق الفقه ولأن معرفة الفرق بين الدلالة والأمارة مفتقر إليها في أصول الفقه لأن بعضها أدلة وبعضها أمارة قيل أما العلم فهو الاعتقاد المقتضي لسكون النفس إلى أن معتقده على ما اعتقده عليه
وأما الظن فهو تغليب بالقلب لأحد مجوزين ظاهري التجويز وأما النظر فهو الفكر ولك أن تقول هو الاستدلال والاستدلال هو ترتيب اعتقادات أو ظنون ليتوصل بها إلى الوقوف على الشيء باعتقاد أو ظن واما النظر الصحيح فهو ترتيب للعلوم أو للظنون بحسب العقل ليتوصل بها إلى علم أو ظن والفرق بين كامل العقل ومن ليس بكامل العقل ظاهر في الجملة وليس هذا موضع تفصيله فإن قيل فما معنى وصفكم أصول الفقه بأنها طرق الفقه على جهة الاجمال قيل معنى ذلك أنها غير معينة ألا ترى أنا إذا تكلمنا في أن الأمر على الوجوب لم نشر إلى أمر معين وكذلك النهي والاجماع والقياس وليس كذلك أدلة الفقه لأنها معينة نحو قول النبي صلى الله عليه و سلم الأعمال بالنيات ولهذا كان القول بأن أصول الفقه كلام في أدلة الفقه يلزم عليه أن يكون كلام الفقهاء في أدلة الفقه المعينة كلاما في أصول الفقه فإن قيل فماذا عنيتم بقولكم كيفية الاستدلال ها هنا قيل الشروط والمقدمات وترتيبها الذي معه يستدل بالطرق على الفقه فإن قيل فما مرادكم بقولكم وما يتبع كيفية الاستدلال ها هنا قيل هو القول في إصابة المجتهدين لأنه يتبع كيفية استدلالهم أن يقال هل أصابوا أم لا
باب في قسمة أصول الفقه
أعلم أنه لما كانت أصول الفقه طرقا إلى الأحكام الشرعية وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك وكانت الأحكام الشرعية تلزم المجتهد وغير المجتهد وجب أن يكون لهذا طريق ولذاك طريق وطريق الذي ليس بمجتهد فتوى المجتهد وطريق المجتهد ضرباناحدهما البقاء على حكم العقل إذا لم ينقل عنه شرع وذلك يقتضي ذكر الحظر والاباحة ليعلم ما يجوز أن ينتقل بالشرع عن حكم العقل وما لا يجوز أن ينتقل
والآخر ما يرد من حكيم أو ما هو طريق إلى ورود ذلك من حكيم كالاجتهاد وما يرد من حكيم ضربان أحدهما مستنبط كالقياس والآخر غير مستنبط وما ليس بمستنبط ضربان أحدهما أقوال والآخر أفعال والحكيم الصادر عنه الأقوال إما أن يكون حكيما لذاته وهو الله سبحانه وإما أن يكون حكيما لأنه معصوم من الخطأ وهو ضربان أحدهما آحاد الأنبياء والآخر جماعة الأمة والأقوال إما أن تكون أصلا في الافادة وإما أن تكون تابعة لغيرها في الافادة كالحروف التي إنما تغير فوائد الأسماء والأفعال فتحصل فوائدها متراخية أو متعقبة وما يكون أصلا في الافادة إما أن يفيد معنى مقترنا بزمان وهو الأفعال وإما أن يفيد معنى غير مقترن بزمان وهو الأسماء ويدخل في الأفعال الأمر والنهي والأسماء إما أن تكون شاملة وإما أن تكون خاصة وإما أن تدل على طريق الإجمال أو لا على طريق الإجمال وهو المجمل والمبين ولا يخلو الكلام إما أن لا يفيد رفع حكم دليل شرعي أو يفيد ذلك وهو الناسخ وهذه الأفعال والأقوال نتكلم فيها على وجهين أحدهما كلام في غاية الاجمال من غير تعيين أصلا نحو أن نبين فوائدها وما ضعت له والآخر كلام أقل إجمالا من ذلك نحو أن ننظر هل الأقوال التي عرفنا فوائدها هي التي في القرآن والسنة فقط أو يضم إلى ذلك ما في كتب المتقدمين من الأنبياء ويدخل في ذلك أبواب سنذكرها
وأما كيفية الاستدلال بالأدلة على الأحكام فالمرجع به إلى كيفية ترتيب الشروط والمقدمات التي معها يستدل بالأدلة على الاحكام الشرعية ويصح أن يحمل معها خطاب الحكيم إذا تجرد على حقيقته دون مجازه وعلى مجازه مع القرينة وذلك يوجب أن نتكلم في الحقيقة والمجاز ليصح أن نعلم ما حقيقة الأمر والنهي والعموم فيصح حمل ذلك على حقائقه وذلك يقتضي أن نقسم الكلام قسمة تنتهي إلى الحقيقة والمجاز ونتكلم في إثباتهما وحدهما ونذكر ما يفصل به بينهما ونذكر أحكامهما ونتبع الكلام في كيفية الاستدلال على الأحكام النظر في المستدلين على الأحكام هل هم مصيبون على اختلافهم أم
لا فحصلت أبواب أصول الفقه هذه أقسام الكلام وذكر الحقيقة والمجاز وفوائد الحروف والأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وطرق الأحكام وكيفية الاستدلال بالأدلة وصفة المفتي والمستفتي وإصابة المجتهدين
باب ترتيب أبواب أصول الفقه
أعلم أنه لما كانت أصول الفقه هي طرق الفقه وكيفية الاستدلال بها وما يتبع كيفية الاستدلال بها وكان الأمر والنهي والعموم من طرق الفقه وكان الفصل بين الحقيقة والمجاز تفتقر إليه معرفتنا بأن الأمر والنهي والعموم ما الذي يفيد على الحقيقة وعلى المجاز وجب تقديم أقسام الكلام وذكر الحقيقة منه والمجاز وأحكامهما وما يفصل به بينهما على الأوامر والنواهي ليصح أن نتكلم في أن الأمر إذا استعمل في الوجوب كان حقيقة ثم الحروف لأنه قد يجري ذكر بعضها في أبواب الأمر فلذلك قدمت عليها ثم نقدم الأوامر والنواهي على باقي الخطاب لأنه ينبغي أن يعرف فائدة الخطاب في نفسه ثم نتكلم في شمول تلك الفائدة وخصوصها وفي إجمالها وتفصيلها ونقدم الأمر على النهي لتقديم الإثبات على النفي ثم نقدم الخصوص والعموم على المجمل والمبين لأن الكلام في الظاهر اولى بالتقديم من الخفي ثم نقدم المجمل والمبين على الأفعال لأنهما من قبيل الخطاب ولأن المجمل كالعموم في أنه يدل على ضرب من الإجمال فجعل معه وتقدم الأفعال على الناسخ والمنسوخ لأن النسخ يدخل الأفعال ويقع بها كما يدخل الخطاب ونقدم النسخ على الإجماع لأن النسخ يدخل في خطاب الله سبحانه وخطاب رسوله صلى الله عليه دون الاجماع ونقدم الأفعال على الاجماع لأنها متقدمة على النسخ والنسخ متقدم على الاجماع ولأن الأفعال كالأقوال في انها صادرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وإنما قدمنا جملة أبواب الخطاب على الاجماع لأن الخطاب طريقنا الى صحته ولأن تقديم كلام الله سبحانه وكلام نبيه أولى ثم نقدم الإجماع على الأخبار لأن الأخبار منها آحاد ومنها تواتر أما الآحاد فالإجماع أحد ما يعلم به وجوب قبولها وهي أيضا أمارات فجاورنا بينها وبين القياس وأما المتواتر فإنها وإن كانت طريقا إلى معرفة الإجماع فانه يجب تأخيرها عنه كما أخرناها عن الخطاب لما وجب أن نعرف الأدلة ثم نتكلم في طريق ثبوتها وإنما اخرنا القياس عن الإجماع لأن الإجماع طريق إلى صحة القياس وأما الحظر والاباحة فلتقدمه على الخطاب وجه غير أنه لما كان أكثر الغرض بهذا الكتاب الأدلة الشرعية المحضة قدمت على الحظر والاباحة على الكلام في طريق الأحكام الذي هو أقل إجمالا لأنا تكلمنا قي الحظر والاباحة على ضرب من الاجمال كما تكلمنا في الأمر والنهي فجعلنا الحظر والاباحة في هذه الجملة ثم انتقلنا إلى الكلام في الطرق التي هي اقل إجمالا وقدمناه على كيفية الاستدلال بها لأن كيفية الاستدلال بها فرع عليها ثم تكلمنا في كيفية الاستدلال بطرق الأحكام وقدمنا جملة هذه الأبواب على صفة المفتي والمستفتي لأن المفتي إنما يجوز له أن يفتي إذا عرف جميع ما ذكرناه من الأدلة وكيفية الاستدلال بها والمستفتي إنما يجوز له أن يستفتي إذا لم يعرف ذلك فصار الكلام في المفتي والمستفتي فرعا عى المعرفة بجملة ما تقدم وبعد ذلك ننظر في إصابة المجتهد إذا اجتهد لنفسه أو ليفتي غيره
فقد أتينا على ذكر الغرض بالكتاب وقسمة أبوابه وترتيبها ونحن نشرع في أبواب الكتاب ونذكر كل باب في موضعه الذي يليق به إن شاء الله عز و جل
باب في حقيقة الكلام وقسمته
اعلم أن الكلام هو ما انتظم من الحروف المسموعة المتميزة وقد دخل فيذلك كل ما هو كلام كالحرفين فصاعدا لأن الحرفين موصوفان بأنهما من الحروف وبهذا الحد ينفصل الكلام مما ليس بكلام لأنه ينفصل مما ليس بحروف ومن حروف الكتابة لأنها غير مسموعة ومن أصوات كثيرة من البهائم لأنها ليست بحروف متميزة ومن الحروف الواحد نحو الزاي من زيد لأنه ليس يوجد في الحرف الواحد انتظام ومن حد الكلام بانه المفيد يلزمه أن تكون الاشارة والعقد كلامين ومن شرط في كونه كلاما وقوع المواضعة عليه يلزمه أن لا يكون الحروف المؤلفة كلاما إذا لم يقع عليها الاصطلاح مع أن أهل اللغة قسموا الكلام إلى المهمل والمستعمل فوصفوا المهمل بأنه كلام وإن لم يوضع لشيء وليس يبعد أن يشترط في كون الحروف كلاما وقوع الاصطلاح عليها وأن يوصف المهمل بأنه كلام على سبيل المجاز لأن ما سمعناه يصل بين حرفين نحو التاء مع التاء والألف مع الألف لا يوصف بأنه متكلم فإن علم أن ذلك مصطلح عليه وصف بأنه متكلم فإذا ثبت ذلك قلنا الكلام هو ما انتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع على استعمالها في المعاني وإذا حددنا الكلام بهذا كان الكلام كله مستعملا وقسمناه هكذا الكلام منه ما يفيد صفة فيما استعمل فيه ومنه ما لا يفيد صفة فيما استعمل فيه وإن حددناه بالحد الأول قلنا في قسمته الكلام ضربان مهمل ومستعمل فالمهمل لم يوضع في اللغة لشيء والمستعمل هو ما وضع ليستعمل في المعاني وهو ضربان أحدهما يفيد صفة فيما استعمل فيه والاخر لا يفيد صفة فيما استعمل فالأول كقولنا أسود وطويل والثاني ضربان أحدهما فيه معنى الشمول والآخر ليس فيه معنى الشمول أما الأول فكقولنا شيء فإنه وضع لكل ما يصح أن يعلم والآخر أسماء الأعلام كقولنا زيد وذلك أن من سمى ابنه زيدا فإنه لا يجب أن يشارك بينه وبين غيره في الاسم والألقاب تجري مجرى الاشارة لأن اللقب لا يفيد فيه صفة مخصوصة ولا مجموع صفاته ألا ترى أنه ينقص بعض صفاته وأعضائه ويزيد له صفة أخرى من طول وسمن ولا يتغير اسمه ويجوز أن تتغير الألقاب على الشخص مع أن
اللغة باقية وإنما جاز ذلك لأن تسمية هذا الشخص زيدا لم تكن توضع من واضعي اللغة حتى إذا سلبناه عنه كنا قد خالفنا لغتهم وليس كذلك إذا سلبنا اسم الطويل عن الطويل وعوضناه منه اسم القصير لأن ذلك تغيير لوضعهم فلم يجز ذلك مع أننا متكلمون بلغتهم
فصار الكلام على ضربين أحدهما مستعمل بوضع اهل اللغة وليس بلقب والآخر لقب فاللقب لا يدخله الحقيقة والمجازعلى ما سنذكره وما ليس بلقب يدخله الحقيقة والمجاز
فقد أتينا على حد الكلام وقسمته حتى انتهينا إلى ذكر الحقيقة والمجاز ونحن نذكر معنى الحقيقة والمجاز وتقسيمهما ونذكر احكامهما وما ينفصل به أحدهما من الآخر إن شاء الله
باب في إثبات الحقيقة والمجاز وفي حدها
أما إثباتهما في اللغة فظاهر في الجملة لقول أهل اللغة هذا الاسم حقيقة وهذا الاسم مجاز وإذا عرفنا ماهيتهما تكلمنا في إثباتهما على التفصيل فأما حدهما فهو أن الحقيقة ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به وقد دخل في هذا الحد الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية والمجاز هو ما أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب فيهافان قيل فيجب إذا قال الواضع سموا هذا حائطا أو قال قد سميت هذا حائطا أن لا يكون قوله حائط في تلك الحال حقيقة للحائط قيل كذلك نقول لأنه لم يتقدم ذلك مواضعة فيكون قد أفاد بقوله حائط ما اقتضته تلك المواضعة ولا يكون أيضا مجازا لأنه لم يتقدمه
مواضعة بخلاف ما أفاد به الآن فيكون مجازا فا قيل فيجب إذا أفاد المتكلم بكلامه معناه العرفي أو الشرعي أن يكون مجازا لأنه غير المواضعة الأصلية قيل هو مجاز بالاضافة إلى المواضعة ألأصلية وليس بمجاز بالاضافة إلى المواضعة العرفية لأنه لم يفد به في الاصطلاح معنى غير ما وضع له وكذلك القول في الاسم الشرعي
وقد حد الشيخ أبو عبد الله أخيرا الحقيقة بأنها ما أفيد بها ما وضعت له وحد المجاز بأ نه ما أفيد به غير ما وضع له وهذا يلزم عليه أن يكون من استعمل اسم السماء في الأرض قد يجوز به لأنه قد أفاد به غير ما وضع له فان قيل من استعمل اسم السماء في الأرض لا يكون قد أفاد به الأرض لأنها لا تعقل منه قيل وكذلك من استعمل اسم الأسد في الشجاع لا يفهم منه الرجل الشجاع فان قلتم يفهم ذلك إذا دلنا على أنه أراد به الرجل الشجاع قيل لهم وكذلك يفهم من قوله السماء الأرض إذا دلنا على أنه أراد ذلك فان قال إنما أردنا بقولنا ما أفيد به غير ما وضع له أنه إذا أطلق المتكلم الاسم جوز السامع أن يكون المتكلم قد استعمله في المجاز وهذا غير قائم فيمن استعمل السماء في الأرض قيل هذا يلزمكم عليه أن يكون الاسم مجازا وإن استعمله المتكلم في حقيقته لأن السامع له يجوز أن يكون عني به مجازا وفي ذلك كون الأسماء كلها مجازا وأيضا فما يجوز من قصد المتكلم باللفظة لا يقال إنه مستفاد منها فان قيل أردنا بقولنا ما أفيد به غير ما وضع له أنه إذا دل المتكلم على أنه ما أراد بكلامه الحقيقة علم أنه أراد المجاز ولا يلزم على ذلك أن يكون اسم السماء مجازا في الأرض وإن عناها المتكلم بقوله سماء لأن المتكلم إذا دل على أنه لم يرد الحقيقة ولم يستفد منه أنه أراد الأرض قيل أليس لو دل على أنه أراد الأرض عقل منه الأرض كما لو دل على أنه أراد به المجاز عقل منه المجاز وإنما لم يعقل الأرض من كلامه إذا قرن بكلامه دلالة مخصوصة وأنتم
لم تذكروا في حد المجاز ما أفيد به غير ما وضع له بدلالة مخصوصة حتى لا يبطل بما ذكرناه
وقد حد الشيخ أبو عبد الله رحمه الله أولا الحقيقة بأنه ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل وحد المجاز بأنه ما لا ينتظم لفظه معناه إما لزيادة أو لنقصان أو لنقل عن موضعه فالذي لا ينتظم لفظه مناه لأجل زيادة هو الذي ينتظم المعنى إذا أسقطت الزيادة نحو قوله سبحانه ليس كمثله شيء فان الكاف زائدة فمتى أسقطناها صار ليس مثله شيء وأما الذي لا ينتظم المعنى لأجل النقصان فهو الذي ينتظمه إذا زدنا في الكلام ما نقص منه نحو قوله عز و جل وسئل القرية لأنه قد اسقط من الكلام أهل القرية ومثال نقل من موضعه قول القائل رأيت الأسد وهو يعني الرجل الشجاع
ولقائل أن يقول إن المجاز لأجل الزيادة والنقصان قد نقل عن موضعه إلى موضع آخر فلا معنى لجعله قسمين آخرين لأن المجاز لأجل الزيادة ليس ينتظم لفظه ومعناه لأجل النقل أيضا لأن قوله ليس كمثله شيء يفيد أن لا شيء مثل مثله وقد نقل عن هذا المعنى إلى نفي المثل عن الله سبحانه وكذلك قوله الله سبحانه وسئل القرية موضع لسؤال القرية وقد نقل إلى أهلها
وقاضي القضاة رحمه الله يذهب إلى تصحيح الحد الذي ذكره أبو عبد الله أخيرا ويقول إن ما ذكره أولا هو صفة الحقيقة والمجاز وليس بحد قال لأن الاسم إذا كان تارة حقيقة أو أفيد به غير ما وضع له فيكون مجازا ولقائل أن يقول بل الغير الذي به يكون حقيقة هو أن ينتظم لفظه معناه من
غير زيادة ولا نقصان ولا نقل والذي به يكون مجازا ضد ذلك والذي ينصر به الحد هو أن المجاز مقابل للحقيقة فحد أحدهما يجب كونه مقابلا لو الآخر والمفهوم من قولنا مجاز هو أنه قد يجوز به ونقل عن موضعه الذي هو ألحق به وهذا هو معنى ما حددنا به المجاز فيجب أن يكون حد الحقيقة ما لم ينقل عن موضعه وهذا معنى ما حددنا به الحقيقة
باب قسمة الحقيقة والمجاز
اعلم أن الحقيقة تنقسم بحسب المواضع التي تكون حقيقة فيها وبحسب إطلاق فائدتها وكونها مشروطة وبحسب كيفية دلالتها فأما الأول فهو أن الحقيقة إما أن تكون لغوية وإما عرفية وإما شرعية لأن اللفظ إذا أفاد المعنى على سبيل الحقيقة فإما أن يفيده بمواضعة شرعية أو غير شرعية بل لغوية واللغوية ضربان إما اصلية أو طارئة وهي العرفية والمجاز أيضا قد يكون مجازا في اللغة أو في العرف أو في الشرعوأما القسمة الثانية فهي أن اللفظة إذا أفادت فائدة على الحقيقة فإما أن تفيدها على الإطلاق وإما بشرط فالأول كقولنا طويل يفيد ما اختص بالطول في أي جسم كان وهذا ضربان أحدهما يفيد فائدة واحدة والآخر يفيد أكثر من فائدة واحدة والثاني نحو قولنا أبلق يفيد اجتماع البياض والسواد بشرط أن يكون في الخيل
وأما القسمة الثالثة فهي أن الحقيقة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا
وذلك أنها إما أن تستقل إفادتها بنفسها ولا تفيد على طريق التبع وإما أن تفيد على طريق التبع ولا تستقل بنفسها كالحرف فانه يفيد فائدة ما دخل عليه نحو الفاء المفيدة للتعقيب بين شيئين والواو المفيدة للجمع والأول ضربان أحدهما يفيد ما يفيده مع زمان وهو الفعل والآخر يفيد بلا زمان
وهو الاسم واعلم أنا قد نصف الكلام بأنه مفيد ونعني أنه موضوع لفائدة وانه مستعمل فيها وهذا حاصل في اللفظ المفرد وقد نعني بذلك أنه يفيد اتصال المعاني بعضها ببعض وهذا لا يكون في اللفظ المفرد لأنه لا يفيد اتصال بعض المعاني ببعض ولا يفيد تصوره معناه لأن معناه متصور لنا قبل اللفظ والكلام المفيد إيصال بعض المعاني ببعض وتعلق بعضها ببعض إما أن يكون اسما مع اسم وإما أن يكون إسما مع فعل أما الأسماء فانه لا يمتنع أن يكون فوائد بعضها صفاتا لبعض فيفهم من اتصالها فوائدها بعضها ببعض كقولنا زيد أحول وزيد طويل وأما الفعل مع الاسم فانه لا يمتنع أن يكون فائدة الفعل مستندة إلى فائدة الاسم فيستفاد من اتصال الفعل الاسم إسناد الفعل المسمى بذلك الاسم تقدم الاسم أم تأخر كقولك زيد يضرب أو يضرب زيد وليس الفعل يلتئم مع الحرف بفائدة ولا به بالاسم لأن الحرف إنما ينبىء عن كيفية إيصال فائدة بفائدة نحو الواو المفيدة للاشراك والفاء المفيدة للتعقيب وليس يدخل تحت الاسم الواحد ولا تحت الفعل الواحد فائدتان فيكون الحرف مفيدا لكيفية إيصال أحدهما بالأخرى فأما قولنا يا زيد ففيه إضمار أمره بشيء أو نهيه عن شيء أو إخباره عن شيء معناه يا زيد أقبل او لا تفعل أو هل في الدار عمرو والمنادى يجد من نفسه أنه يضمر ذلك وربما أظهره ولهذا إذا سمعه المنادي قال ما الذي تريد فدل على أنه قد عقل منه إضمار ما ذكرناه وقد قيل إن قول القائل يا زيد معناه انادي زيدا ولو كان هذا كما قالوا لكان قد أفاد الاسم مع الحرف هذه الفائدة وفي ذلك نقض قولهم وأما الفعل فانه لما كان حدثا لم يصح أن يسند إليه حدث آخر ولا أن ينعت وإنما يجوز أن ينعت من حيث كان صورة ولهذا كان قولنا لزيد انظر حسنا معناه انظر نظرا حسنا والاسم إذا نعت بالاسم فانعقدت به الفائدة كان خبرا والفعل إذا قرن بالاسم فإما أن يقرن به على سبيل النعت فيكون خبرا وما في معناه كقولك زيد يضرب وإما أن يقرن به على سبيل الحدث إما على الفعل فيكون أمرا وإما
على تركه فيكون نهيا فبان أن الخطاب المفيد إما أن يكون أمرا وما في معناه أو خبرا أو ما في معناه وأيضا فان من خاطب غيره فإما أن يكون في حكم من يعطيه شيئا أو يأخذ منه شيئا فالأول هو الباعث إما على الفعل أو على الترك وأما المعطي فهو المخبر وما في معناه كالمتمني فأما الاستفهام والاستخبار فهما طلب الفهم والخبر فهما في معنى الأمر والباعث على الفعل أو على الترك إما أن يكون أعلى رتبة من المبعوث فيكون بعثه أمرا وإما أن يكون دونه فيكون سؤالا وإما أن يكون مساويا فيكون طلبا ويبعد أن يكون سؤالا لما في السؤال من انخفاض الرتبة ويبعد أن يكون أمرا لما في الأمر من علو الرتبة وقد ذكر أكثر هذه القسمة الأخيرة من تقدم
فأما قاضي القضاة رحمه الله فانه قسم الكلام المفيد إلى الأمر والنهي وما في معناهما وإلى الخبر فقال المخاطب لغيره إما أن يفيد حال نفسه فيدخل فيه الأمر والنهي لأن الأمر ينبىءعن إرادة الآمر والنهي ينبىء عن كراهته واما أن ينبىء عن حال غيره فيكون الخبر وإذا علم أن كل واحد منهما قد يدخل في الآخر لأن الانسان قد ينبىء عن حال نفسه بالخبر وينبىء عن حال غيره بالأمر والنهي لأنهما يدلان على وجوب الفعل وقبحه وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكره قسمة متقابلة لأن الأقسام المتقابلة يجب أن يكون بعضها غير بعض وذلك يمنع من دخول بعضها في بعض
فقد أتينا على أقسام الحقيقة ونحن نبين أن في اللغة الحقيقة المفردة والمشتركة ليصح أن ننظر هل الأمر من الألفاظ المشتركة كما قاله قوم أم لا ونبين أن في اللغة المجاز ليصح أن ننظر في الأمر هل هو حقيقة في الوجوب أو مجاز ونبين أنه يحسن أن يكون في القرآن مجاز ليصح أن نحمل كثيرا من الآيات التي يستدل بها خصومنا في كثير من مسائل هذا الكتاب على المجاز ونبين ثبوت الحقائق الشرعية والعرفية لدخولهما في القسمة التي ذكرناها وليصح أن ننظر هل الأمر وغيره منقولان إلى الواجب بالشرع أم لا ثم نذكر ما ينفصل به
الحقيقة من المجاز ونذكر أحكام الحقيقة وأحكام المجاز ونؤخر الكلام في هل يصح أن يراد بالعبارة الواحدة الحقيقتان إلى المجمل لأن ذلك لم يصح فاللفظ المفيد لهما مجمل محتاج إلى بيان ولو صح أن يراد بها كان ذلك من قبيل العموم فأما ما يريده الحكيم بخطابه إذا أفاد في اللغة والعرف والشرع فوائد مختلفة فنذكره عند كيفية الاستدلال بخطاب الحكيم لأن هناك نذكر الشروط التي معها يجب أن يريد المتكلم ما يريد الحكيم وهناك نذكر ما يريد الحكيم من هذه الوجوه
باب إثبات الحقائق المفردة والمشتركه
اعلم أن في اللغة الفاظا مفيدة للشيء الواحد على الحقيقة وألفاظا مفيدة للشيء ولخلافه وضده حقيقة على طريق الاشتراك أما الأول فلا شبهة فيه ولو لم يكن في اللغة حقيقة لم يكن فيها مجاز لأن المجاز هو ما أفيد به غير ما وضع له وفي ذلك كونه موضوعا لشيء لو عبر به عنه لكان حقيقة فيه ولو لم يكن في اللغة حقيقة ولا مجاز لكان الكلام قد خلا منهما وذلك محال وأما الثاني فقد ذهب إليه أكثر الناس ومنع منه قوم قالوا لأن الغرض بالمواضعة تمييز المعاني بالأسماء ليقع به الإفهام فلو وضعوا لفظة واحدة لشيء ولخلافه على البدل لم يفهم بها أحدهما وفي ذلك نقض الغرض بالمواضعة ودليل جواز ذلك أنه لا يمتنع أن تضع قبيلة اسم القرء للحيض وتضعه أخرى للطهر ويشيع ذلك ويخفي كون الاسم موضوعا لهما من جهة قبيلتين فيفهم من إطلاقه الحيض والطهر على البدل وأيضا فإن المواضعة تابعة للأغراض وقد يكون للانسان غرض في تعريف غيره شيئا مفصلا وقد يكون غرضه بأنه يعرفه مجملا مثال الاول أن يشاهد زيدا سوادا ويريد أن يعرف عمرا أنه شاهدسوادا ومثال الثاني أنه يريد تعريفه أنه شاهد لونا ولا يفصله له فجاز أن يضعوا اسما تطابق كل واحد من الغرضين وهذا الوجه والذي قبله جواب عما تعلق به المخالف وقول أهل اللغة شفق وقرء من أسماء الأضداد وأنه مشترك يدل على ثبوت الأسماء المشتركة في اللغة وليس لأحد أن يتعسف التأويل فيجعل قولنا قرء مفيدا للطهر والحيض فائدة واحدة لأن ذلك إنما يسوغ لو امتنع كون ذلك في اللغة
باب الحقائق الشرعية
ذهب شيوخنا والفقهاء إلى أن الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر ونفى قوم من المرجئة ذلك وبعض عللهم تدل على أنهم أحالوا ذلك وبعضها تدل على أنهم قبحوه ونحن نذكر ما الاسم الشرعي ثم نبين إمكان نقل الاسم بالشرع عن معناه اللغوي ثم نبين حسن ذلك ثم نبين أن من الأسماء ما قد انتقل بالشرعأما الاسم الشرعي فذكر قاضي القضاة أنه ينبغي أن يجمع شرطين أحدهما أن يكون معناه ثابتا بالشرع والآخر أن يكون الاسم موضوعا له بالشرع وينبغي أن يقال الاسم الشرعي هو ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى وقد دخل تحت ذلك أن يكون المعنى والاسم لا يعرفهما أهل اللغة وأن يكونوا يعرفونهما غير أنهم لم يضعوا الاسم لذلك المعنى وأن يكونوا عرفوا المعنى ولم يعرفوا الاسم كل هذه الأقسام داخل فيما ذكرناه
فأما الدلالة على إمكان نقل الأسماء فهي أن كون الاسم اسما للمعنى غير واجب له وإنما هو تابع للاختيار بدلالة انتفاء الاسم عن المعنى قبل المواضعة وأنه كان يجوز أن يسمى المعنى بغير ما سمي به نحو أن يسمى البياض سوادا إلى غير ذلك فاذا كان كذلك جاز أن يختار مختار سلب الاسم عن معناه
ونقله إلى غيره إذ كان ذلك تابعا للاختيار فان قالوا لو سلب الاسم عن المعنى وعوض غيره انقلبت الحقائق قيل إنما يلزم ذلك لو استحال انفكاك الاسم عن المعنى وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك
فأما الدلالة على حسن نقل الاسم عن معناه إلى معنى آخر بالشرع فهي أنه لا يمتنع تعلق مصلحة بذلك كما لا يمتنع ثبوتها في جميع العبادات ولا يكون فيه وجه قبح وإذا لم يمتنع ذلك لم يمتنع حسنه إذ المصلحة وجه حسن وأيضا فقد جاءت الشريعة بعبادات لم تكن معروفة في اللغة فلم يكن بد من وضع اسم لها لتتميز به من غيرها كما يجب ذلك في مولود يولد للإنسان وفي آله يستحدثها بعض الصناع ولا فرق بين أن يوضع لتلك العبادة اسما مبتدأوبين أن ينقل إليهما اسم من أسماء اللغة مستعمل في معنى له شبه بالمعنى الشرعي بل نقل اسم لغوي إليه أولى لأنه أدخل في أن يكون الخطاب لغويا فان قالوا إنما قبح نقل الاسم عن معناه إلى معنى آخر لأنه يقتضي بغير الأحكام المتعلقة به نحو أن يأمرنا الله سبحانه بالصلاة ونعني به الدعاء فإذا نقل الاسم إلى هذه الأركان بغير الغرض قيل هذا يمنع من نقل اسم عن معناه إذا كان قد تعلق به فرض ولا يمنع من نقل اسم لم يتعلق به فرض وأيضا فلو نقل الله سبحانه اسم الصلاة عن الدعاء لم يسقط فرض الدعاء عن المكلفين ولو أوجب ذلك سقوط الدعاء عنهم لأمكن أن يدلنا الله على بقاء الفرض بأن يقول ما كنت أوجبته عليكم فوجوبه باق عليكم
فأما الدلالة على أن الشرع قد نقل بعض الأسماء فهي أن قولنا صلاة لم يكن مستعملا في اللفة لمجموع هذه الأفعال الشرعية ثم صار اسما لمجموعها حتى لا يعقل من إطلاقه سواها إن قيل قولنا صلاةموضوع في اللغة للاتباع ألا تراهم يسمون الطائر مصلياإذا اتبع السابق وهو واقع على الصلاة لأنها اتباع للإمام فقد افاد في اللغة ما أفاده في الشرع قيل هذا يقتضي أن لا تسمى صلاة الإمام والمنفرد صلاة وأن يكون من أطلق اسم
الصلاة في الشريعة فإنما نعني به ونفهم منه الاتباع ومعلوم أنه لا يخطر ببال السامع والمتكلم إلا جملة هذه الأفعال دون الاتباع فان قالوا اسم الصلاة كان في اللغة للدعاء وسميت الصلاة الشرعية بذلك لأن فيها دعاء فلم تختلف فائدته قيل إن عنيتم أن اسم الصلاة واقع على جملة هذه الأفعال لأن فيها دعاء فقد سلمتم ما نريده من إفاده الاسم لما لم يكن يفيده في اللغة ولا يضرنا أن تعللوا وقوع الاسم على هذه الأفعال بما ذكرتم وإن أردتم أن اسم الصلاة واقع على الدعاء من جملة هذه الأفعال دون مجموعها فذلك باطل لأن المفهوم من قولنا صلاة جملة الأفعال والمفهوم من قولنا فلان في الصلاة أنه في جزء من هذه الأفعال دعاء كان أو غيره والمفهوم من قولنا فلان قد خرج من الصلاة أنه قد فارق جملة الأفعال ولو كان الأمر كما ذكروه لوجب إذا قلنا إنه قد خرج من الصلاة أفاد أنه قد خرج من الدعاء وإذا عاد إلى الدعاء جاز أن يقال قد عاد الآن إلى الصلاة
دليل آخر هو أن قولنا صوم كان يفيد في اللغة الامساك وهو مفيد في الشريعة إمساكا مخصوصا وقولنا زكاة يفيد الطهرة والنماء ويفيد في الشرع طهرة مخصوصة وما يؤدي إلى النماء إن قالوا لو كان قولنا صلاة منقولا إلى معنى شرعي لوجب كونه محصلا مفهوما وليس الأمر كذلك وليس لكم أن تقولوا إنه يفيد التحريم والقراءة والركوع والسجود لأن صلاة الأخرس لا قراءة فيها وصلاة الجنازة وصلاة المريض المومىء لا ركوع فيها ولا سجود وإذا لم يكن ذلك معقولا علمنا أن الاسم ما انتقل والجواب أنه يبطل بما ذكروه أن يكون قولنا صلاة نقل إلى معان مختلفة وليس يمتنع ذلك كما لا يمتنع كون الاسم اللغوي مشتركا بين اشياء مختلفة وإنما يتخصص ما وضع له قولنا صلاة بالاضافة إما إلى الوقت وإما إلى أحوال المصلي وأحواله إما إغراضه وإما غير ذلك أما الوقت فنحو قولنا صلاة عيد وصلاة جمعة وصلاة كسوف وصلاة ظهر وعصر وغير ذلك فإن كل واحد من ذلك يفيد غير ما يفيده الآخر إما بزيادة وإما بنقصان وأما أغراض المصلي
فنحو صلاة الجنازة فان غرض المصلي أن يفعلها لأجل الميت وأما أحواله التي هي الأعراض فضربان أحدهما حال عذر والآخر حال سلامة أما حال السلامة فصلاة الصحيح المقيم الآمن وأما حال العذر فضربان أحدهما حال تعذر كصلاة الأخرس والمريض والمومىء والآخر حال مشقة كصلاة المسافر والخائف والله أعلم
باب في الحقائق العرفية
ينبغي أن نذكر ما الاسم العرفي ثم نبين إمكان نقل الاسم بالعرف ثم نبين حسنه ثم نبين ثوبته ثم كيفية الانتقال ثم أمارة الانتقال ثم نقسم الأسماء العرفيةأما الاسم العرفي فهو ما انتقل عن بابه بعرف الاستعمال وغلبته عليه لا من جهة الشرع أو نقول ما أفاد ظاهره لاستعمال طارىء من أهل اللغة ما لم يكن يفيده من قبل إن قيل أليس قولنا دابة يفيد في العرف الفرس وهو يفيد في اللغة أيضا لأنه يفيد في اللغة ما يدب والفرس مما يدب فلم يفد في العرف ما لم يكن يفيده في اللغة وهو من الأسماء العرفية والجواب أنه إن كان يفيد في اللغة الاشتقاق من الدبيب وكان يقع على كل شخص يدب على البدل وهو مفيد في العرف شخصا مخصوصا من الحيوان فلم يفد ما كان يفيده في اللغة من الاشتقاق من الدبيب والوقوع على الفرس وعلى غيره
وأما إمكان نقل الاسم بالعرف فقد بان بما بان به إمكان نقله بالشرع
وأما حسن ذلك فالذي يبينه أنه قد يحصل في انتقال الاسم غرض صحيح وما يحصل فيه ذلك فهو حسن لأنه لو قبح ما قبح إلا لأنه لا غرض فيه ومعلوم أنه قد تنفر الطباع عن بعض المعاني وتتجافى النس التصريح بذلك
فيكنون عنه باسم ما انتقل عنه وذلك كقضاء الحاجة المكنى عنه باسم المكان المطمئن من الأرض الذي تقضى فيه الحاجة وقد سموا ما يدب دابة فلما كان الدبيب في بعض الحيوان أشد واسرع أو كانوا له أكثر مشاهدة وكان اهتمامهم به لشرفه عندهم أشد كثر استعمال قولهم دابة فيه فيصير هو المفهوم عندإطلاقه لكثرة استعمالهم الاسم فيه وذلك هو الفرس
وأما انتقال الاسم بالعرف فبيانه هو أن قولنا دابة كان يفيد كل ما دب ثم خص بالعرف بالفرس وقولنا راوية كان للجمل ثم صار بالعرف للمزادة وقولنا غائط كان للمكان المطمئن من الأرض ثم صار لقضاء الحاجة
وأما كيفية انتقال الاسم بالعرف فهو أنه يتعذر مع كثرة أهل اللغة أن بتواطئوا على ذلك ولكنه لا يمتنع أن ينقل الاسم طائفة من الطوائف ويستفيض فيها ويتعدى إلى غيرها فيشيع في الكل على طول الزمان ثم ينشأ القرن الثاني فلا يعرفون من إطلاق ذلك الاسم إلا ذلك المعنى الذي نقل إليه
فأما أمارة انتقال الاسم فهو أن يسبق إلى الأفهام عند سماعه معنى غير ما وضع له في الأصل فإن كان السامع للاسم يتردد في فهمه المعنى العرفي واللغوي معا كان الاسم مشتركا فيهما على سبيل الحقيقة
فأما قسمة الأسماء العرفية فهي أن العرف إما أن يجعل الاسم مستعملا في غير ما كان مستعملا فيه في اللغة وإما أن لا يجعله مستعملا في غيره وهذا الأخير لا يكون إلا بأن يستعمله في بعض ما كان يفيده في اللغة كقولنا دابة وأما ما استعمل في غير ما كان يفيده في اللغة فضربان أحدهما أن يكون الاسم قد صار مجازا فيما كان حقيقة فيه في اللغة والآخر أن تبقى حقيقته فيه حتى يكون مشتركا بين المعنى اللغوي والعرفي فالأول كاسم الغائط والثاني كقولنا كلام زيد فانه حقيقة في كلامه الذي هو فعله وفيما هو حكاية عن كلامه والله أعلم
باب إثبات المجاز في اللغة
وذهب أكثر الناس إلى ذلك وحكي عن قوم المنع منه وليس يخلو خلافهم في ذلك إما أن يكون خلافا في معنى أو في عبارة والخلاف في المعنى ضربان احدهما أن يقولوا إن اهل اللغة لم يستعملوا الأسماء فيما تقول إنها مجاز فيه نحو اسم الحمار في البليد وهذا مكابرة لا يرتكبها أحد والآخر أن يقولوا إن أهل اللغة وضعوا في الأصل اسم الحمار للرجل البليد كما وضعوه للبهيمة وهذا باطل لأ نا كما نعلم باضطرار أنهم يستعملون ذلك في البليد فإنا نعلم أنهم استعملوا ذلك على طريق التبع والتشبيه للبهيمة وأن استحقاق البليد لذلك ليس كاستحقاق البهيمة ولذلك يسبق إلى الأفهام من قول القائل رأيت الحمار البهيمة دون البليد ولو كان موضوعا لهما على سواء لم يسبق إلى الأفهام أحدهما فإن قيل فإذا كان الحقائق تعم المسميات فلماذا تجوز بالأسماء عن ما وضعت له قيل لأن في المجاز من المبالغة والحذف ما ليس في الحقيقة ولهذا إذا وصفنا البليد بانه حمار كان أبلغ في الإبانة عن بلادته من قولنا بليد وقد يحصل الكلام مجازا بضرب من الحذف فيستعمل ذلك طلبا للتخفيفوأما الخلاف في الاسم فبأن يسلم المخالف أن استعمال اسم الحمار في البليد ليس بموضوع له في الأصل وأنه بالبهيمة أخص لكنه يقول لا أسميه مجازا إذا عني به البليد لأن أهل اللغة لم يسموه بذلك بل أسميه مع قرينته حقيقة فيقال له إن أردت أن العرب لم تسمه بذلك فصحيحي وإن أردت أن الناقلين عنهم لم يسموه بذلك فباطل بتلقيبهم كتبهم بالمجاز وبأنهم يقولون في كتبهم هذا الاسم مجاز وهذا الاسم حقيقة وليس إذا لم تسمه العرب بذلك يمتنع أن يضع الناقلون عنهم له هذا الاسم ليكون آلة وأداة في صنائعهم لأن أهل الصنائع يفعلون ذلك ولهذا سمى النحاة الضمة المخصوصة
رفعا والفتحة نصبا ولم يلحقهم بذلك عيب وأما تسمية الخصم مجموع الاسم والقرينة حقيقة فانه لو صح ذلك لم يقدح في تسمية أهل اللغة الاسم بانفراد مجازا على ما حكيناه عنهم على أن الوصف بالمجاز وبالحقيقة يرجح إلى اللفاظ لأنها هي المستعملة في المعاني دون القرائن لأن القرائن قد تكون شاهد حال وغير ذلك مما ليس من فعل المتكلم
باب في حسن دخول المجاز في خطاب الله وفي أنه قد خاطب به
ذهب الجمهور إلى أن الله سبحانه فد خاطبنا في القرآن بالمجاز ونفى بعض أهل الظاهر ذلك والدليل على حسن ذلك أن إنزال الله عز و جل القرآن بلغة العرب يقتضي حسن خطابة إياها فيه بلغتها ما لم يكن فيه تنفير كالكلام السخيف المنسوب قائله إلى العي وليس هذه سبيل المجاز لأن أكثر الفصاحة إنما تظهر بالمجاز والاستعارة وأما الدلالة على ان في القرآن مجازا فقول الله عز و جل جدارا يريد ان ينقض فاقامه وقوله وجاء ربك وقوله إلى ربها ناظرة وليس يخلو المخالف إما أن يقول إن هذه الألفاظ وضعت في الأصل للمعاني التي أرادها الله وهذا قد أفسدناه من قبل وإما أن يقول إن هذا الكلام كان مجازا في اللغة لهذه المعاني ثم نقل إليها بالشرع فصار من الحقائق الشرعية وهذا باطل لأنه لو كان كذلك لسبق إلى أفهام أهل الشرع معانيها التي أرادها الله كما سبق إلى أفهامهم الصلاة الشرعية عند سماعهم اسم الصلاة ومعلوم أنه لا يسبق إلى الأفهام عند سماع قول الله عز و جل إلى ربها ناظرة إلى ثواب ربها ناظرةاحتج المخالف بأشياء
منها أن المجاز لا ينبىء عن معناه بنفسه فورود القرآن به يقتضي الإلباس والجواب أنه لا إلباس مع القرينة الدالة على المراد
ومنها قولهم إن العدول إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة وذلك مستحيل على الله والجواب أن ذلك إنما يقتضي العجز عن الحقيقة لو لم يحسن العدول إلى المجاز مع التمكن من الحقيقة ومعلوم أن العدول إلى المجاز يحسن لما فيه من زيادة فصاحة واختصار ومبالغة في التشبيه ولو لم تكن في المجاز هذه الوجوه لجاز ان يكون فيه مصلحة لا نعلمها ولجاز أن يكون المجاز مع قرينته يساوي في الطول كثرة ألفاظ فيجري العدول إليه مجرى العدول من حقيقة إلى حقيقة
ومنها قولهم لو خاطب الله بالمجاز والاستعارة لصح وصفه بأنه متجوز في خطابه وبأنه مستعيرا والجواب أن إطلاق وصفه بالتجويز يوهم التسمح بالقبيح ولهذا إذا قيل فلان متجوز في أفعاله أفاد أنه متسمح بالقبيح فيها وأما قولنا مستعير فإنه يفهم من إطلاقه أنه استأذن غيره في التصرف في ملكه لينتفع به وكل ذلك يستحيل على الله عز و جل
باب ذكر ما يفصل به بين الحقيقة والمجاز
اعلم أن الفصل بينهما إنما يكون من جهة اللغة إما بنص من اهل اللغة وإما باستدلال بعاداتهم والأسبق إلى أفهامهم وبما يجب للحقيقة والمجازأما الأول فنحو أن يقولوا هذه حقيقة وهذا مجاز أو يقولوا هذا الكلام إذا عني به كذا فقد عني به ما وضع له وإذا عني به كذا لم يكن قد عني به ما وضع له أو يقولوا إذا عني به كذا لم ينتظم لفظه معناه إما بزيادة او نقصان أو بنقل وإذا عني به كذا ينتظم لفظه معناه من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل
وأما الاستدلال فبأن يسبق إلى إفهام أهل اللغة عند سماع اللفظة من دون قرينة معنى من المعاني دون آخر فيعلموا أنها حقيقة فيما سبق إلى الفهم لأنه لولا أنه قد اضطر السامع من قصد الواضعين إلى أنهم وضعوا اللفظة لذلك المعنى ما سبق إلى فهمه ذلك المعنى دون غيره ووجه آخر أن يكون أهل اللغة إذا أرادوا إفهام غيرهم معنى من المعاني اقتصروا على عبارة مخصوصة وإذا عبروا عنه بغيرها لم يقتصروا عليها فيعلموا أن العبارة التي اقتصروا عليها هي حقيقة في ذلك المعنى لأنه لولا ما استقر في أنفسهم من استحقاق ذلك المعنى لتلك اللفظة وانها تفيده وحده ما اقتصروا عليها
وقد فرق بينهما بالاطراد ونفيه فمتى اطرد الاسم في معنى على الحد الذي استعمل فيه من غير منع شرعي كان حقيقة فيه ومتى لم يطرد فيه من غير منع كان مجازا لأن المجاز لا يطرد ألا ترى أن وصفنا للرجل الطويل بأنه نخلة لما كان مجازا لم يطرد في كل طويل والصحيح أن نفي الاطراد من غير منع دليل على أن الاسم مجاز لأنه قد ثبت وجوب اطراد الاسم في حقيقته واطراده لأنه يدل على أنه حقيقة لأن المجاز وإن لم يجب اطراده فلا مانع يمنع من اطراد بعضه وما ذكروه من التمثيل بالنخلة فهو مثال واحد ولا يمكن أن يدعى انه قد استقرئت الألفاظ كلها فلم يوجد فيها مجاز مطرد ولو كان ذلك قد علم لكان قد علمت ألفاظ المجاز وعلم أن ما عداها حقيقة قبل العلم بنفي اطرادها وذلك يقتضي أن يكون الفصل بينهما قد علم قبله
وقد فرق بينهما بأن اللفظة إذا افادت الشيء على الحقيقة يصرف فيها بجمع وتثنية واشتقاق وتعلق بالغير نحو اسم الأمر إذا وقع على القول فإنه يتعلق بالمأمور به فيقال هو أمر بكذا وإذا لم يجمع الاسم ولم يثن ولم يشتق منه لم يكن حقيقة ولهذا لم يكن استعمال اسم الأمر في الفعل حقيقة لأنه لا يقال فيه إنه أمر بكذا وذلك أنه إذا تصرف في اللفظة علم أنها متمكنة في معناها وهذا تقريب لأن اسم الحمار إذا وقع على البليد ثني وجمع فقيل في جماعة
البلد حمير وقولنا رائحة تقع على الرائحة حقيقة ولا يشتق منه وقيل أيضا إذا علمنا استعمال أهل اللغة اللفظة في شيء ولم يدل دلالة على أنها مجاز فيه كانت حقيقة فيه ولقائل أن يقول إنما علمنا أنها حقيقة لعلمنا أنها غير مجاز وإنما علمنا أنها غير مجاز لنفي ادلة المجاز عنها وعن تلك الأدلة يسئلون فما هي وقيل أيضا إن الشيء إذا سمي باسم ما هو جزاء عنه كقول الله عز و جل وجزاء سيئة سيئة مثلها أو باسم ما يؤدي إليه كالنكاح أو باسم ما يشبهه كتسمية البليد حمارا كان مجازا ولقائل أن يقول إن للتشبيه والجزاء وغير ذلك وجوها لأجلها تجوزوا وليست أمارات للمجاز لأنه لا يمتنع أن يستعملوا الاسم في الشيء وفيما يشبهه وفيما هو جزاء عنه وفيما يؤدي إليه أصل الوضع فينبغي أن يعلم أن الاسم مجاز فيها هو جزاء عنه ثم يعلم أنهم إنما تجوزوا فيه لأجل ذلك وقيل إذا علقت الكلمة بما يستحيل تعلقها به علم أنها مجاز فيه نحو قول الله عز و جل وسئل القرية وهذا الوجه لا يصح لأنا إنما علمنا بالعقول أن القرية لم ترد فأما أن اسم القرية مجاز في أهلها فيحتاج إلى دلالة لأنه لا يجب إذا لم يرد المتكلم معنى من المعاني بكلامه وأراد غيره أن يكون الكلام مجازا في ذلك الغير ألا ترى أن الكلمة لو كانت مشتركة بين حقيقتين وعلمنا استحالة إرادة الحكيم لأحدهما وأنه قد أراد الأخرى لم تكن الكلمة مجازا فيه
باب ذكر أحكام الحقيقة والمجاز
اعلم أن من أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يدخلان أسماء الألقاب لأن الحقيقة هي ما أفيد بها ما وضعت له والمجاز هو ما أفيد به معنى غير ما وضع له على ما تقدم ونعني بقولنا ما وضعت له وضع أهل اللغة وكون اللفظ حقيقة ومجازا تبعا لكونها موضوعة لشيء قبل استعمال المستعمل حتى إن استعملها المستعمل فيما وضعت له كانت حقيقة وإن استعملها في معنى آخر كانت مجازا وأسماء الألقاب لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من اهل اللغة ولا من الشرع حتى يكون من اتبعهم فيها في اصل موضوعهم كان قد استعملها على الحقيقة ومن استعملها فيه على طريق التبع كان متجوزا بها
ومن احكام الحقيقة والمجاز أن لا يخلو منهما كلام وضعه أهل اللغة لشيء واستعمله المستعمل فيما استعملوه لأن المتكلم به إذا عني به ما عناه اهل اللغة فإما أن يعني به ما عنوه في الأصل فيكون حقيقة أو على سبيل التبع فيكون مجازا
ومن احكام الحقيقة والمجاز أنه لا يجوز أن يكون اللفظ مجازا في شيء ولا يكون حقيقة في غيره ويجوز أن يكون حقيقة في شيء ولا يكون مجازا في غيره أما الأول فلأن المجاز هو ما أفيد به معنى في المواضعة غير ما وضع في أصلها وهذا تصريح بأنه قد وضع في الأصل لشيء آهر فاللفظة متى استعملت فيه كانت حقيقة وأما الثاني فلأن الحقيقة هي ما افيد بها ما وضعت له وليس يوجب كونها موضوعة لشيء أن تكون مستعملة في غيره على طريق التبع
ومن حكم اللفظ أن يحمل على حقيقتة إذا تجرد ولا يحمل على مجازه إلا لدلالة لأن واضع الكلام للمعنى إنما يضعه ليكتفي به في الدلالة عليه وليستعمله فيه فكأنه قال إذا سمعمتوني أتكلم بهذا الكلام فاعلموا أنني أعني به هذا المعنى وإذا تكلم به متكلم بلغتي فليعن به هذا فكل من تكلم بلغته فيجب أن يعني به ذلك المعنى ولهذا يسبق إلى أفهام السامعين ذلك المعنى دون ما هو مجاز فيه ولو قالوا لنا في المجاز مثل ذلك لكان حقيقة ولم يكن مجازا
والحقيقة قد يجوز أن تصير بالشرع او بالعرف مجازا فيما كانت حقيقة فيه ويجوز أن يصير بهما المجاز حقيقة فيما كان مجازا فيه
ومن حكم الحقيقة أن تطرد في فائدتها على الحد الذي يفيدها إما مشروطة أو مطلقة إلا أن يمنع من ذلك مانع مثال المطلقة قولنا طويل يفيد ما اختص بالطول فإذا علمنا أن أهل اللغة سموا الجسم طويلا عند اختصاصه بالطول ولولا ذلك ما سموه طويلا علمنا أنهم سموه بذلك لأجل طوله فسمينا كا جسم فيه طول بأنه طويل ومثال المشروطة تسميتهم ما وجد فيه السواد والبياض من الخيل بانه ابلق فانا نطرد ذلك في كل فرس وجدا فيه دون سائر الأجسام وهذا هو معنى قولنا إن القياس مستعمل في الحقائق
والمخالف في ذلك إما أن يخالف في الاسم أو في المعنى فإن وافق في المعنى وخالف في الاسم فقوله من جهة العبارة باطل لأنه قد أعطى معنى القياس وهو إثبات حكم الشيء في غيره بالرد إليه لعلة من العلل وإن خالف في المعنى فمن وجهين أحدهما أن يمنع من تعدى الاسم إلى غير ما شاهده أهل اللغة وإن وقعت المساواة في فائدة الاسم وهذا إن قاله ففيه انقطاع اللغة وليس كذلك إذا لم يطرد المجاز لأن الحقائق مستوعبة للمسميات وليس يمنع من اطراد الحقائق قول الله سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها لأن ذلك إنما يقتضي تعليمه أسماء ما حضره دون ما يحدث ولأن نص الله سبحانه له على الأسماء لا يمنع من لم ينص له أن يقيس على أنه إذا لم يجز أن تكون الأسماء كلها توقيفا وجب تخصيص قول الله عز و جل وعلم آدم الأسماء كلها
والوجه الآخر أن يطرد المخالف الاسم في معناه إلا أن يقول إنما فعلت ذلك لعلمي باضطرار من قصد واضعي اللغة أنهم سموا بقولهم طويل كل ما اختص بالطول مما حدث ومما سيحدث ويمكن أن يقال اه في ذلك إنما علمت ذلك لعلمك أنهم سموا الطويل طويلا لاختصاصه بالطول وأنه إذا
كان هذا غرضهم وجب طرده ويقال له فهب أنك علمت ذلك ضرورة أليس لو لم تعلم ذلك ضرورة وعلمت أنهم سموا الطويل طويلا لاختصاصه بالطول لا غير لكنت تعلم أن كل ما حصل ذلك فيه فيجب أن يسمى طويلا فلا بد من يلي فيقال له فقد تم غرضنا من وجوب اطراد الحقائق
فأما المانع من اطراد الحقيقة فضربان
أحدهما أن يكثر استعمالها في المجاز كثرة توهم المجاز ولا يجوز إطلاقها في موضع لا يحسن إيهام ذلك المجاز فيه نحو وصف الله عز و جل بأنه دليل عند من يقول إن قولنا الدليل حقيقة في فاعل الدلالة لأنه قد كثر استعماله في الدلالة فصار إطلاق ذلك يوهم
والضرب الاخر السمع فإنه منع من تسمية الله بأنه فاضل وإن أفاد المدح
وأما المجاز فينبغي أن يقر في كل نوع ما استعمل فيه ولا يعدى عنه إلى غيره نحو تسميتهم الرجل الطويل بأنه نخلة فإنه يجوز أن يسمى كل رجل طويل بذلك ولا يجب أن يسمى غير الرجال بذلك والحقيقة تتعدى النوع ولهذا لما سموا الرجل الأسود بأنه أسود جرى ذلك على غيره من الأجسام السود ولو اطرد المجاز كاطراد الحقيقة لما كان بينهما فصل فإن قيل الفصل بينهما أن الحقيقة أصلية والمجاز طارىء قيل قد أجيب عن ذلك بأن الحقيقة قد تطرأ أيضا على الحقيقة فإن قيل الفصل بينهما أن المجاز يحتاج في حمله على ما هو مجاز فيه إلى دلالة وليس كذلك الحقيقة قيل بل قد تحتاج الحقيقة إلى دليل إذا كان اللفظ مشتركا بين حقيقتين ولقائل أن يقول الفصل بينهما أن المجاز لا يسبق إلى الفهم ما هو مجاز فيه ويسبق إلى الفهم ما اللفظ حقيقة فيه سواء كان حقيقة في معنى واحد أو اكثر
ويمكن أن يحتج لنفي اطراد المجاز بأن المتجوز بالاسم في غير ما وضع له إنما يرخص فيه لغرض لا يجب أن يوجد في غيره نحو أن يكون قد اهتم بذلك
الشيء فدعاه بشدة اهتمامه به إلى أن يبالغ في وصفه فيشبهه بغيره نحو تسميتهم الرجل الطويل بأنه نخلة ولا يجب حصول هذا الغرض في غير الناس ولكنه قائم في كل رجل وقع الاهتمام به فإن قيل فقد طردتم المجاز في نوعه قيل إن أريد باطراده هذا فذلك لا نأباه فإن قيل فلعلهم تجوزوا بالنخلة في الطويل بشرط كونه من الرجال فيطرد الاسم فيما وجد فيه شرطه دون ما عدم فيه شرطه فيتساوى الحقيقة والمجاز في ذلك قيل هذا تسليم لما نريده من أن المجاز لا يتعدى نوعه وإن عللتموه بما ذكرتم ولقائل أن يقول إذا كانوا قد تجوزوا باسم النخلة في الرجل الطويل على طريق المبالغة في وصفه بالطول لاهتمامهم فيجب إذا حصل هذا الغرض في غيره من الأجسام أن يتجوزوا بهذا الاسم فيه وفي ذلك اطراد الاسم والجواب أنه إذا كان الغرض قد لا يحصل في كل موضع
فقد تم ما أردناه من نفي وجوب اطراد المجاز
باب القول في الحروف
اعلم أن الكلام لما انقسم إلى الاسم والفعل والحرف وكان الخطاب تتغير فوائده بالحروف الداخلة عليه وكان أكثر الغرض بهذا الكتاب ذكر الخطاب الذي يستدل به على الأحكام وجب أن نذكر فيه الحروف أيضافنقول إن من الكلم ما يدخل في الكلام فيغير فائدته وينبىء عن حال بعضه عند بعض وقد يكون ذلك اسما وقد يكون حرفا وذلك ينبىء عن تعلق بعض معاني الكلام ببعض إما على سبيل المشاركة أو لا على سبيل المشاركة
فالاول إما أن ينبىء عن مشاركة على البدل أو على الجمع فالأول لفظ أو تقول جالس زيدا أو عمرا فتكون قد شركت بينهما في الجلوس على البدل وقد يكون أو بمعنى الشك تقول سلمت على زيد أو عمرو
وأما الثاني وهو الذي ينبىء عن المشاركة على الجمع فإنه إما أن ينبىء عن المشاركة فقط وغما أن ينبىء عن وقت المشاركة فالمنبىء عن المشاركة فقط هو الواو كقولك رأيت زيدا وعمرا فيفيد أنهما اشتركا في الرؤية وقد تكون الواو بمعنى الاستئناف كقول الله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إذا وقع الابتداء بقوله والراسخون في العلم وقيل إنها بمعنى أو كقول الله سبحانه أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع قيل إن المراد به أو ثلاث أو رباع ويمكن أن يقال إنما وضعت جملة الملائكة بذلك فاقتضى أن بعضهم على الصفة الأولى وبعضهم على الصفة الثانية وبعضهم على الصفة الثالثة فيكون المراد بالواو الجمع أي أن ذلك اجتمع لجملة الملائكة وأما المنبىء عن وقت المشاركة فإما أن يفيد أن المشاركة حصلت في وقت واحد كقولك رأيت زيدا مع عمرو وإما أن يفيد التقديم كقولك قبل أو التاخر وهذا إما أن لا يفيد تقدير التأخير بزمان أو يفيد ذلك فالأول نحو بعد والثاني إما أن لا يفيد تقدير التأخر بزمان طويل وإما بزمان قصير فالأول ثم فإنها تفيد الترتيب والتراخي وقيل إنها يتجوز بها فيستعمل بمعنى الواو كقول الله سبحانه فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد لأنه لا يجوز أن يكون شاهدا بعد أن لم يكن شاهدا والثاني الفاء وذلك انها تفيد التعقيب الممكن بين الفعلين كقولك دخلت البصرة فالكوفة يفيد أن دخولك الكوفة كان بعد دخولك البصرة بزمان يسير جرت العادة بمثله وليس يجب أن يكون بينهما من الزمان اليسير مثل ما يكون بين لقاء زيد وعمرو إذا قلت لقيت زيدا فعمرا لأنه يمكن في هذا من الزمان اليسير ما لا يمكن في ذلك
وأما ما ينبيء عن تعلق بعض المعاني ببعض لا من جهة المشاركة فإنه إما أن
يكون ظرفا أو ابتداء من الظرف أو انتهاء إليه فالأول ضربان أحدهما أن يفيد ذلك بلفظ الباء والآخر بلفظ في أما الأول فقول الله سبحانه وامسحوا برءوسكم قال قاضي القضاة إن اللغة تفيد تعميم الرأس لأن المسح معلق بما يسمى رأسا وجملة الرأس تسمى رأسا دون أبعاضه والعرف يقتضي إلحاق المسح بالرأس إما جميعه وإما بعضه لأن المعقول من قولنا مسحت يدي بالمنديل في العرف ما ذكرناه وعند الشيخ أبي عبد الله أن قول الله برءوسكم مجمل يحتاج إلى بيان لأنه قد ترد هذه اللفظة ويراد بها الكل وقد ترد ويراد بها البعض والأول ما ذكره قاضي القضاة وأما لفظه في فقولنا زيد في الدارفيكون الدار ظرفا له وقد يقال زيد في الصلاة تشبيها بالظرف لأنه لما انقطع إلى الصلاة عن غيرها جرى مجرى من انقطع إلى مكان دون غيره
وأما الابتداء فلفظه من تقول خرجت من البصرة إلى الكوفة وقد تكون صلة في الكلام كقول الله سبحانه يغفر لكم من ذنوبكم المراد يغفر لكم ذنوبكم وقيل إنها تكون للتبعيض كقول القائل أكلت من هذا الخبز وقولنا باب من حديد والصحيح أن قولنا باب من حديد يفيد الجنس دون التبعيض لأنه لو لم يكن في الوجود حديد إلا ذلك الباب لقيل باب من حديد
وأما الانتهاء فلفظه إلى تقول سرت من البصرة إلى بغداد والغاية والحد قد يدخلان في الخطاب وقد لا يدخلان فيه وقال أبو عبد الله إن الغاية لما دخلت مرة ولم تدخل أخرى كانت مجملة والصحيح أنها لا تفيد الدخول في الخطاب لأن قول الله سبحانه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يفيد إيجاب غسل اليد بكون نهايته المرافق ومن غسل يده إلى أول
المرافق صدق عليه القول بأن غسله ليديه كان نهايته المرافق فيكون بذلك فاعلا لما اقتضاه الظاهر فسقط عنه الأمر وإنما يعلم وجوب غسل المرافق بدليل زائد كما أن من قيل له ادخل الدار ففعل ما يقع عليه اسم دخول إلى الدار يسقط عنه الأمر إذ الأمر يسقط بوجود أول الاسم وكذلك من خرج من البصرة إلى بغداد يقال قد انتهى إلى بغداد فبان أنه ليس من شرط الغاية أن يدخل في الخطاب
فأما الواو العاطفة فإنها لا تقتضي الترتيب وقال بعض الشافعية إنها تقتضي الترتيب ودليلنا أن الإنسان إذا قال رأيت زيدا وعمرا لم يسبق إلى الفهم أنه رأى زيدا قبل عمرو ولهذا لو قال رأيت زيدا وعمرا بعده أفاد فائدة محددة وأيضا فانها لو أفادت الترتيب لكان قول القائل رأيت زيدا وعمرا معا أو قبله إما مناقضة أو مجازاكما أن قول القائل رأيت زيدا ثم عمرا معا أو قال ثم عمرا قبله مناقضة وأهل اللغة لم يجعلوا ما ذكرنا مناقضة ولا مجازا فان قيل أليس لفظة ثم تفيد التراخي ويجوز أن يقول القائل جاءني زيد ثم جاءني عمرو عقيبه ولا يجوز أن يقال تراخى مجيء عمرو عن مجيء زيد غير أنه جاء عقيبه فهلا كانت الواو تجري مجرى ثم في الترتيب ويتجوز بها في الجمع ولا يتجوز بلفظة ثم في ذلك قيل إنا لا نمنع أن تقوم لفظة مقام لفظة فيتجوز باحداهما في شيء ولا يتجوز بالأخرى فيه وإنما الذي احتججنا به هو أن أهل اللغة لم يجعلوا هذا الكلام مناقضة ولا مجازا على أنه لا يحسن أن يقال جاءني زيد ثم عمرو عقيبه
دليل قال أهل اللغة إن واو العطف في الأسماء المختلفة تجري مجرى واو الجمع وياء التثنية في الأسماء المتماثلة وإنهم لم يتمكنوا من جمع الأسماء المختلفة بواو الجمع استعملوا فيها واو العطف ولما كان قول القائل رأيت الزيدين وجاءني الزيدون يفيد اشتراكهم في المجيء والرؤية ولا يفيد الترتيب فكذلك إذا قال جاءني زيد وعمرو وخالد فان قيل لا يمتنع أن تكون
واو العطف تقوم مقام واو الجمع في إفادة الاشتراك وتختص بافادة الترتيب كما أن ثم والفاء تجمعان بين الشيئين في العطف وتجريان في ذلك مجرى واو الجمع وتختصان بافادة الترتيب والجواب أن أهل اللغة لو أرادوا أن واو العطف تجري مجرى واو الجمع في إفادة الاشتراك فقط وأفادت الترتيب لقالوا أيضا إن لفظة ثم والفاء قد أجريتا مجرى واو الجمع وياء التثنية أيضا فلما لم يقولوا ذلك في ثم والفاء وقالوا ذلك في الواو علمنا أن واو العطف تقوم مقام واو الجمع في إفادة الجمع فقط
دليل قال أهل اللغة إن الواو لا تفيد الترتيب وقولهم بأجمعهم حجة في اللغة فان قالوا قد حدكي عن الفراء أنه قال الواو لا تفيد الترتيب إلا حيث يستحيل الجمع نحو قول الله سبحانه يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا قيل هذا يدل على أنه جعلها للترتيب لأجل دلالة وهو تعذر الجمع وفي هذا موافقة أهل اللغة وإذا ثبت أن ظاهرها لا يقتضي الترتيب لم يكن تعذر الجمع دليلا على وجوب الترتيب لأنه يمكن أن يتقدم السجود على الركوع ولو أفادت الترتيب بظاهرها إذا تعذر الجمع لأفادته إذا صح الجمع وصح الترتيب
وقد استدل على أن الواو لا تفيد الترتيب بأنها لو افادته لدخلت في جواب الشرط كالفاء ومعلوم أنه لا يحسن أن يقول القائل إذا دخل زيد الدار وأعطه درهما ولقائل أن ينقض ذلك بلفظة ثم ولفظة بعد وأيضا فإن الواو وإن اقتضت عندهم الترتيب فانها تفيد العطف ولا يمكن العطف فيما ذكروه لأنه لم يتقدم ما تكون الواو عاطفة عليه
واستدل على ذلك أيضا بأن الجمع من غير ترتيب معقول فلم يكن بد من لفظة تفيده في اللغة وليس في الألفاظ ما تفيده إلا الواو وليس يجوز أن
تكون لفظة مع هي التي تفيد ذلك لأن لفظة مع تفيد الاشراك في زمان واحد والذي يجب أن يكون في اللغة هو لفظة لا تفيد إلا الاشراك فقط ولقائل أن يقول في اللغة ما يفيد ذلك غير الواو وهو قول القائل رأيت زيدا رأيت عمرا وإن احتج الذاهبون إلى الترتيب بأن الانسان إذا قال رأيت زيدا وعمرا علمنا أنه لولا أنه راى زيدا قبله لما بدأ به قيل له فاذا الترتيب استفيد من البداية بزيد لا من أجل الواو ويلزم على ذلك أن يستفاد التنرتيب من قول القائل رايت زيدا رأيت عمرا وعلى أنه يجوز أن يكون إنما بدأ بزيد لأنه أراد الإخبار عنه فقط ثم بدا له في الإخبار عن عمرو ويجوز أن يكون بدأ به بمحبته له أو لأن اهتمامه بالإخبار عنه أشد من الاهتمام بالاخبار عن عمرو أو لأن غرضه في الإخبار عن كل واحد منهما على السواء فكان البداية بأحدهما كالبداية بالآخر فبدأ بما اتفق منهما
الكلام في الأوامر
باب فصول الأمر
اعلم أن صيغة الأمر لما وضع لها اسم يفيدها ووضعت هي لفائدة ويجوز أن تكون مطلقة ويجوز أن تكون مقيدة بشرط أو صفة ولها أمثال يجوز أن تتكرر وهي أيضا من جملة الأفعال يجوز أن تحسن وتقبح وجب لذلك أن يقع الكلام في الأمر من هذه الوجوهأما الأول فبأن ننظر هل اسم الأمر يفيد على طريق الحقيقة صيغة الأمر فقط أو يفيد غيرها أيضا على طريق الحقيقة ونبين أن اسم الأمر إذا وقع على الصيغة ما الذي يفيد فيهما
وأما الوجه الثاني وهو فائدة الأمر فانه لما كان الأمر هو بعث من آمر لمأمور على إيقاع فعل في زمان وجب أن ننظر في فائدته في هذه الأشياء كلها فننظر في فائدته في الفعل الذي هو بعث عليه وفيما يتبع ذلك الفعل
أما نظرنا في فائدته من الفعل فمن وجوه منها أن ننظر هل فائدته في الفعل واحدة أو أكثر وإن كانت واحدة فهل هي وجوب الفعل أم لا وإن أفاد وجوب الفعل فهل يفيد وجوبه وإن تقدمه حظر الفعل ام لا ولما كان الأمر قد يتعلق بالفعل وبالأفعال الكثيرة على التخيير نظرنا هل إذا تعلق بأفعال على البدل أفاد الوجوب فيها على البدل أم لا وليس يليق هذا
الباب بأبواب العموم لأن أحدا لا يقول إن الأمر يقتضي وجوب جميع تلك الأفعال على الجمع وننظر أيضا هل يقتضي الأمر إجراء الفعل أم لا
وأما النظر في فائدته فيما يتبع الفعل فبأن ننظر هل يقتضي وجوب ما لا يتم المأمور به إلا معه أم لا وهل يقتضي قبح أضداد المأمور به أم لا
وأما النظر في فائدته في الوقت فان الأمر إما أن يكون مقيدا بوقت محدود وإما أن لا يكون مقيدا بوقت فيجب أن ننظر فييما ليس بمقيد هل يقتضي التكرار أم لا وفيما هو مشروط بشرط يتكرر هل يقتضي التكرار بتكرار الشرط أم لا وإن لم يفد مطلقة التكرار هل يجب تقديم فعل المرة أم لا وهل إذا لم يقدمها المكلف اقتضى الأمر فعلها فيما بعد أم لا وإن كان الأمر مقيدا بوقت محدود له أول وآخر نظرنا هل يوجب الأمر الفعل في جميعه على البدل أو يوجب تقديمه في أوله أو يوجب تأخيره إلى آخره وهل إذا عصى المكلف المأمور به اقتضى الأمر فعله بعده أم لا
وأما النظر في فائدته الملتحقة بالآمر فبأن ننظر هل يدخل فاعل الأمر في الأمر أم لا
وأما النظر في فائدته فيما يرجع إلى المأمور فبأن ننظر هل يدخل الكافر والمرأة والعبد والصبي في مطلقه أم لا وإذا تناول جماعة وكان بعضهم يقوم مقام بعض في ذلك الفعل هل يفيد الإيجاب على جميعهم على البدل أم لا غير أن الكلام في دخول الكافر والمرأة والعبد والصبي يليق بأبواب العموم والخصوص لأنه كلام في شمول الخطاب لهم ونفي شموله لهم ومن يقول إنهم يدخلون تحت الخطاب يقول ذلك لأن لفظ العموم يشملهم ومن قال لا يدخلون فيه أو بعضهم يقول إن فقد تمكنهم من الفعل يخرجهم عن الخطاب
وأما الكلام في الوجه الثالث وهو الأمر المفيد بشرط وصفة فننظر فيه هل
يجوز أن يؤمر الانسان بشرط زوال المنع وننظر أيضا هل إذا كان الايجاب معلقا بشرط أو صفة أو غاية فما عدا ذلك ينتفى عنه الايجاب أم لا يلزم ذلك
وأما الكلام في الوجه الرابع وهو تكرار الأمر فبأن ننظر إذا تكرر بحرف عطف أو بغير حرف عطف هل تتكرر فائدته أم لا
وأما الوجه الخامس فإنا ننظر في شرائط حسن الأمر
ونحن بمعونة الله نأتي على الكلام في هذه الأبواب على النسق إن شاء الله عز و جل
باب فيما يقع عليه قولنا أمر على سبيل الحقيقة
اعلم أنه لا شبهة في أن قولنا أمر يقع على جهة الحقيقة على القول المخصوص وذلك غير مفتقر إلى دلالة واختلفوا في وقوعه على الفعل فقال أكثر الناس إنه يقع عليه على سبيل المجاز وقالت طائفة من أصحاب الشافعي إنه يقع عليه على سبيل الحقيقة وقالت لذلك إن أفعال النبي عليه السلام على الوجوب لأنها داخلة تحت قول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره وأنا أذهب إلى أن قول القائل أمر مشترك بين الشيء والصفة وبين جملة الشأن والطرائق وبين القول المخصوص يبين ذلك أن الانسان إذا قال هذا أمر لم يدر السامع أي هذه الأمور أراد كما أنه إذا قال إدراك لم يدر ما الذي أراد من الرؤية واللحوق فاذا قال هذا أمر بالفعل أو قال أمر فلان مستقيم أو قال قد تحرك هذا الجسم لأمر من الأمور وجاءنا زيد لأمر من الامور عقل السامع من الأول القول المخصوص ومن الثاني الشأن ومن الثالث أن الجسم تحرك لصفة من الصفات وشيء من الأشياء وأن زيدا جاءنا لشيء من الأشياء أو غرض من الأغراض فبان أن قبولنا أمر مشترك بين هذه الأشياء وأنه يتخصص بواحد واحد منها بحسب ما يقترن به والدلالة على أن قولنا أمر ليس بحقيقة في الفعل أنه لو كان حقيقة فيه والدلالة على أن قولنا أمر ليس بحقيقة في الفعل أنه لو كان حقيقة فيه لاطرد فكان يسمى الأكل أمرا والشرب أمرا كما تقدم فو قولنا أسود
فان قالوا أليس قد يقال في الأكل الكثير هذا أمر عظيم قيل إنما يقال فيه ذلك من حيث هو شيء ألا ترى أنه لا يقال في الفعل القليل إنه أمر ونعني به الفعل وإنما نعني به أنه لا شيء من الأشياء ألا ترى أنه يقال فيه أمر من الامور على حد ما يقال ذلك فيما ليس بفعل
فان قالوا إن اسم الامر يقع على جملة ما وجد من الأفعال ولا يلزمنا أن يطرد في آحادها لأنا لم نجعله عبارة عن آحادها والجواب إنا وإنما تكلمنا على من جعل اسم الأمر عبارة عن آحاد الأفعال وهو مذهبكم ولهذا استدللتم بقول الله سبحانه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر والمراد بذلك عندكم كل فعل من أفعاله فأما من قال هو عبارة عن جملة الأفعال فقد أبعد أن اسم الأمر يتناول جملة شأن الانسان أفعاله وغير أفعاله ولا طريق إلى العلم بان جملة الافعال وحدها يقع عليها هذا الاسم ألا ترى أن قول القائل أمر فلان مستقيم وهذا يدخل فيه شأنه وطرائقه أفعاله وغير أفعاله
ومما احتج به على أن اسم الأمر لا يتناول الفعل حقيقة هو أنه لو تناوله على الحقيقة لوجب أن يشتق لفاعله منه اسم آمر وهذا لا يصح لأنه قد
بينا أنه لا يجب الاشتقاق من الحقائق ألا ترى أن قولنا رائحة يقع على الرائحة حقيقة ولا يشتق منه وكذلك قولنا لون وكذلك طعم فانه ليس من أمارة الحقيقة التثنية والجمع لأن اسم الحمار إذا وقع على البليد ثني وجمع مع أنه مجاز فيه ولا يلزمنا نحن من وجه آخر لأنا إذا جعلناه عبارة عن شأن الانسان وذلك يدخل فيه فعله وغير فعله لم يجز أن يشتق منه اسم آمر لأن ذلك ينبىء عن الفعلية يعني الاشتقاق
ومنها أنه كان يجب أن يقال في فاعل الفعل أمر بكذا وأن يلزم الفعل الطاعة والمعصية كالقول وهذا لا يصح لان للقوم أن يقولوا نحن نجعله مشتركا بين القول الذي يتعدى فيقال فيه إنه أمر بكذا وبين الفعل الذي لا يتعلق بغيره ويتعدى إليه ولا يقال فيه أمر بكذا ولا يلزمه الطاعة والمعصية وهكذا الجواب إن استدل به علينا في وقوعه على الشأن
واحتج من جعله واقعا على الفعل حقيقة بوجوه
منها قول الله سبحانه وما أمر فرعون برشيد والجواب أنه لا يمتنع أن يكون أراد قوله ولهذا قال فاتبعوا أمر فرعون والاتباع إنما يكون في القول
ومنها قوله سبحانه وتعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر والجواب أنه ليس المراد بذلك أن فعله كلمح بالبصر وإنما المراد بذلك أن من صنعته وشأنه أنه إذا أراد شيئا وقع كلمح البصر في السرعة
ومنها قولهم قد خولف بين جمع الأمر إذا أفاد القول وبين جمعه إذا أفاد الفعل فقيل في الأول أوامر وفي الثاني امور فدل على أنه حقيقة فيهما والجواب أنه قد حكي عن أهل اللغة أن الأمر لا يجمع
أوامر لا في القول ولا في الفعل وأن أوامر جمع آمرة وأيضا فان أمر وامور يقع كل واحد منهما موقع الآخر إن استعمل في الفعل على ما ذكروه وليس أحدهما جمعا للآخر ألا ترى أنه يقال أمر مستقيم فيفهم منه ما يفهم من قولنا اموره مستقيمة وعلى أن اختلاف جمعيهما ليس بأن يدل على أنه حقيقة فيهما بأولى من أن يدل على أنه مجاز في أحدهما وحقيقة في الآخر فان قيل الجمع أحد أدلة الحقيقة وقد جمع الأمر أمورا إذا استعمل في الفعل كان لمن يسلم لهم استعمال اسم الأمر في الفعل أن يجيب بالوجهين الأولين فأما نحن فلا نسلم ذلك وإنما نقول إنه مستعمل في جملة شأن الانسان وأحواله أفعاله وغير أفعاله
ومنها قولهم لو وقع قولنا أمر على الفعل على سبيل المجاز لكان لها مجازا إما بالزيادة وإما بالنقصان وإما بالنقل والتشبيه وليس بين القول والفعل شبه فعلمنا أنه ليس بمجاز فيه وجوابنا أن اسم الأمر ليس يقع على الفعل من حيث هو فعل لا على سبيل المجاز ولا على سبيل الحقيقة وإنما يقع على جملة الشأن حقيقة وهو المراد بقول الناس امور فلان مستقيمة فأما أصحابنا فانهم سلموا وقوع ذلك على الفعل وقالوا إنه مجاز فيه بزيادة معنوية لأن جملة أفعال الانسان لما دخل فيها القول سميت الجملة باسم جزئها وهذا لا يصح لأن الانسان قد يقول أمر فلان في تجارته أو صحته مستقيم ولا يدخل في ذلك أمره الذي هو القول وقيل ايضا إن الأفعال تشبه الأوامر في أن كل واحد منهما يدل على سداد أغراض الانسان ولا يلزم أن يسموا النهي والخبر أمرين لأن المجاز لا يجب اطراده وهذا لا يصح لأن القول المخصوص إنما وقع عليه اسم من حيث كان نعتا مخصوصا على الفعل فكان يجب أن يقع الشبه بينه وبين الفعل من هذه الجهة وإن لم يشتبها في فائدة الاسم من كل وجه يجب أن يكون المتلفظ باسم الأمر إذا عنى به الفعل أن يعني به ما ذكروه من الشبه ومعلوم أن ذلك لا يخطر بباله ألا ترى أن الرجل إنما يجوز اسم الأسد فيه من حيث أشبهه في الشجاعة التي هي
معظم فائدة قولنا أسد ومن يسمي الشجاع أسدا فانه يعني شجاعته
باب في أن قولنا أمر إذا وقع على القول ما الذي يفيد
اعلم أنه يفيد امورا ثلاثة أحدها يرجع إلى القول فقط وهو أن يكون على صيغة الاستدعاء والطلب للفعل نحو قولك لغيرك افعل وليفعل والآخران يتعلقان بفاعل الأمر أحدهما أن يكون قائلا لغيره افعل على طريق العلو لا على طريق التذلل والخضوع والآخر أن يكون غرضه بقوله افعل أن يفعل المقول له ذلك الفعل وذلك بأنه يريد منه الفعل أو بأن يكون الداعي له إلى قوله افعل أن يفعل المقول له الفعل وليس يليق الفصل بين الموضعين باصول الفقهأما الشرط الأول فلا شبهة في أن اسم الأمر يقع حقيقة على ما هو من القول بصيغة افعل أو ليفعل فانه لا يقع على سبيل الحقيقة على الخبر والنهي والتمني ولذلك لا يقال لفاعل ذلك آمر
وأما الشرط الثاني فبين أيضا وهو أولى من ذكر علو الرتبة لأن من قال لغيره افعل على سبيل التضرع إليه والتذلل لا يقال إنه يأمره وإن كان أعلى رتبة من المقول له ومن قال لغيره افعل على سبيل الاستعلاء عليه لا على سبيل التذلل له يقال إنه أمر له وإن كان أدنى رتبة منه ولهذا يصفون من هذه سبيله بالجهل والحمق من حيث أمر من هو أعلى رتبة منه
وأما الشرط الثالث وهو الارادة فمختلف فيه بالخبر به لا بشرطه لقولها إن الله يأمر بالطاعة ولا يريدها ومن الفقهاء من يقول إن الأمر أمر لصيغته وذلك يوهم أنهم يقولون إنه استحق الوصف بانه أمر لصيغته والبغداديون من أصحابنا يقولون إن الأمر أمر لعينه والكلام في هذه المسئلة يكون من وجهين أحدهما أن نفرض أن للأمر حكما لاختصاصه به
يكون امرا ونبين أن الوجه في اختصاصه بذلك الوجه هو الارادة على طريق التعليل والوجه الآخر أن لا يثبت للصيغة حكما يرجع إليها وننظر هل المعقول من قولنا أمر هو الصيغة وحدها أو الصيغة مع شرط آخر هو الارادة وإنما فصلنا بين الوجهين لأن كثيرا من الناس ربما أدخل الكلام في أحدهما في الآخر ونحن نجري الكلام على الوجه الثاني لفساد الوجه الأول فنقول إن المعقول من قولنا إن اللفظة أمر هو أنها على صيغة مخصوصة مفعولة على وجه العلو وأنها طلب للفعل وبعث عليه ولسنا نعقل من هذه اللفظة شيئا آخر وقد تقدم بيان القول في الرتبة والصيغة فأما كون الصيغة طلبا فنحن نشرع في تفصيله فنقول ليس يخلو إما أن تكفي صيغة الأمر في أن تكون طلبا للفعل من غير أن يشرط معها إثبات شيء ولا نفي شيء أو لا تكفي في ذلك فان كفت في ذلك حتى تكون أمرا على أي وجه وجدت عليه لزم أن يكون التهديد أمرا وكلام الساهي أمرا إذا كان على صيغة افعل وإن وجب أن يشرط في كونها طلبا شرط زائدا على صيغتها ووجودها لم يخل إما إن يرجع إلى المأمور أو المأمور به أو إلى الأمر أو إلى محل الصيغة ولا تعلق لمن عداهم بها فيذكر ولا يجوز رجوعه إلى المأمور من كونه محدثا وموجودا وقادرا وغير ذلك ولا إلى المأمور به من كونه حسنا وواجبا وندبا لأن كل ذلك يحصل مع التهديد ألا ترى أن الانسان يهدد على فعل الواجب والحسن وإن رجع ذلك الشرط إلى الآمر لم يخل إما أن يكون من قبيل النفي أو من قبيل الإثبات وما هو من قبيل النفي أن يقال إن الصفة كانت أمرا لأنه لم يدلنا على أنه غير أمر أو أنه لم يدلنا على أنه تهديد أو إباحة ولا ذم كقول الله سبحانه قال اخسئوا فيها ولا تكلمون أو أنها وجدت منه وليس بكاره للفعل أو أنه غير كاره للفعل ولا ساه عنه وأكثر هذه الأقسام يقولها الفقهاء
وأما قولهم إنه لم يدلنا على أنها غير أمر فانه يقال لهم ما معنى قولكم أمر حتى نعقل الدلالة على إثباته أو على نفيه وهل مطلوبنا إلا أن نعقل معنى الأمر ما هو وأما قولهم إذا لم يدلنا على أنها تهديد أو إباحة أو إرشاد فانه يقال لهم قد يهدد من ليس بحكيم غيره ولا يدل على أن ما فعله تهديد لضرب من ضروب السفه ولا تكون الصيغة التي فعلها أمرا ويقال لهم أيضا إذا لم يدلنا على ذلك فانما نقضي بأنها أمر لو كان الأمر هو كلما كان على هذه الصيغة ولم يكن إباحة ولا تهديدا ولا ذما وليس الأمر كذلك لأن كلام الساهي قد خلا من هذه الأقسام وليس بأمر ولا طلب للفعل ولهذا لا يسمى أمرا ولا طلبا وعلى أنه إنما يتم ما ذكروه إذا أعقلونا معنى التهديد حتى يعلم في الصيغة إذا لم يكن تهديدا ولا إباحة أنها أمر فما التهديد فان قالوا هو ما كان على صيغة افعل مع الكراهة للفعل قيل لهم ولم كانت الكراهة شرطا في كون الصيغة تهديدا ونفيها شرطا في كونها أمرا بأولى من أن تكون الارادة شرطا في كون الصيغة طلبا ونفيها أو ضدها شرطا في كونها تهديدا فان قالوا معنى التهديد هو الصيغة بشرط انتفاء الدلالة على كونها أمرا كانوا قد علقوا كونها أمرا بفقد الدلالة على أنها تهديد وعلقوا كونها تهديدا بفقد الدلالة على كونها أمرا وهذا محال فأما الكلام بأن الصيغة إنما كانت طلبا وأمرا لأن المتكلم بها ما كره الفعل فإنه يلزم عليه أن يكون كلام الساهي والعابث أمرا وطلبا لأنه غير كاره للفعل فأما القول بأنها إنما يكون طلبا للفعل إذا كان المتكلم بها غير ساه ولا كاره للفعل ولم يقصد بها الاباحة والذم والتحدي وغير ذلك فانه يقال لهم إذا كان المتكلم غير ساه فلا بد من أن يكون غرضه بإيرادها شيئا من الأشياء فاذا لم يكن غرضه ما ذكرتم فلا بد من أن يكون غرضه إيقاع المأمور به وفي ذلك الرجوع إلى أنه لا بد من غرض وإرادة فقد تم ما ذكرناه من إثبات غرض أو إرادة ويجب أن تكون الصيغة إنما كانت طلبا من حيث طابقت هذا الغرض لا من حيث أن المتكلم بها ليس بساه لأن فقد السهو ليس باثبات للفعل فيكون القول به
طلبا فان قالوا إنما نعني بقولنا إن الامر كان أمرا لصيغته إذا تجردت أي أنها إذا جاءت متجردة من حكيم اكتفينا بذلك في الحكم عليها بأنها أمر وإنما يحتاج في أن المتكلم استعملها في غير الأمر إلى دلالة قيل لهم فهذا موضع وفاق وليس هو مطلوبنا وإنما مطلوبنا ما الذي يفيده قولنا أمر فيها فأحدها مفارق للآخر
فأما ما يرجع إلى الآمر فما هو إثبات فالذي يجوز أن يكون شرطا في ذلك علوه وقدرته وإرادته وكراهاته وليس يجوز أن تكون الشروط في كون الصيغة طلبا للفعل قدرة فاعلها عليها أو علمه بها وبحسنها أم بحسن الفعل أو وجوبه لأنه مع ذلك قد تكون الصيغة تهديدا ولا يجوز أن تكون إنما كانت الصيغة أمرا وطلبا لأن الفاعل لها جعلها بقدرته أمرا وطلبا لأنه تكلمنا مع بطلان القول بأن للأمر حكما وصفة فلا يمكن أن يقال إن القادر جعل الأمر على ذلك الحكم ولأنه ينبغي أن يعرفنا ما معنى كونها أمرا فانا عنه نبحث وبهذا يبطل القول بأنها صارت أمرا لأنه علمها أمرا ولأن الشيء لا يكون على ما هو عليه بالعلم بل ينبغي أن يكون على ما هو عليه حتى يصح أن يتناوله العلم على أن المهدد قد علم كون الأمر أمرا ولا يكون ما يفعله من صيغة التهديد أمرا وليس يجوز أن تكون الصيغة طلبا وأمرا لأن فاعلها كره الفعل لأنه كان يجب كون المهدد آمرا ولا يجوز أن يكون شرط كونها أمرا ما يرجع إلى المحل لأنا نعلقها طلبا وأمرا من غير أن يخطر ببالنا لون المحل وطعمه وغير ذلك لأن ما يرجع إلى المحل قد يثبت والصيغة تارة أمرا وتارة تهديدا فيثبت أنه إنما كان طلبا وأمرا لإرادته ولا تخلو إرادته إما أن تتعلق بالمأمور به وهو قول اصحابنا ولا يجوز أن يكون شرط كونها طلبا إرادة إحداثها لأن هذا حاصل في التهديد ولا يمكن أن يقال إرادة إحداثها أمرا لأنا عن ماهية كونها أمرا نبحث فيجب أن نعقله حتى نعقل تعلق الإرادة به فان قالوا أليس يقول شيوخكم إن الخبر إنما يكون خبرا لارادة كونه خبرا فما أنكرتم من مثله في الأمر قيل إن إرادة كونه خبرا معقولة وهو أن يريد
المتكلم به إخبار زيد وإعلامه ما تضمنه الخبر فقد أعقلنا معنى إرادته لكونه خبرا فينبغي أن يعقلوا بالارادة لكون الصيغة أمرا وقد أفسد ذلك أيضا بأنه كان يجب أن تكون الصيغة أمرا إذا أراد فاعلها أن يكون أمرا وإن كره المأمور به وذلك باطل بالتهديد ولقائل أن يقول إنما لم يكن التهديد أمرا لأن المتكلم به ما أراد كونه أمرا أو يستحيل من جهة الداعي أن يريد كونه أمرا ويكره المأمور به وقيل أيضا كان ينبغي جواز تعلق الأمر بالماضي كالخبر إذا كان إرادة إحداث المأمور به ليس من شرطه ولقائل أن يقول إن الأمر تكليف ولا يجوز تكليف الماضي والجواب أنه إن لم يجب أن يكون الغرض به إيقاع الفعل فليس بواجب أن يكون تكليفا وكان ينبغي صحة تعلقه بالإحداث وبغير الإحداث كالخبر ويكون ما تعلق منه بغير الاحداث قبيحا فصح أن صيغة الأمر إنما تكون طلبا بشرط أن يكون الغرض بها وقوع المأمور به
واحتج المخالف بأشياء
منها أنه لو كان الأمر إنما يكون أمرا إذا أراد الآمر الفعل لما جاز أن يستدل بالأمر على الارادة لأنه لا يعلم أمرا قبل الارادة والجواب أنا لا نستدل على الارادة بالأمر من حيث كان أمرا بل من حيث إنه على صيغة افعل وقد تجرد لأن عند أصحابنا أن هذه الصيغة موضوعة للإرادة وكلام الحكيم يجب حمله على موضوعه إذا تجرد وعندنا أن هذه الصيغة جعلت في اللغة طلبا للفعل فإذا بان لنا أنه لا معنى لكونها طلبا للفعل إلا أن المتكلم بها قد أراد الفعل وأنه هو غرضه علمنا بذلك الارادة عند علمنا بالصيغة
ومنها قولهم إن اهل اللغة قالوا إن الأمر هو قول القائل افعل مع الرتبة ولم يشرطوا الارادة مع انهم شرطوا الرتبة فلو كانت الارادة شرطا لذكروها أيضا فجرى ذلك مجرى كون الأسد مسمى بأنه أسد في أنه لا يشرط فيه الارادة والجواب أنه يجوز أن يكونوا لم يشرطوا الارادة لظهورها
وأيضا فانهم لم يشرطوا انتفاء القرائن والمخالف يشرط انتفائها وأيضا فانهم لم يشرطوا انتفاء القرائن والمخالف يشرط انتفائها وأيضا فانهم لا يختلفون في أن الأمر هو طلب الفعل والقول من بعد في أن الطلب لا يكون إلا مع الارادة وهو تفصيل بحمله وطريقة العقل لأنه كلام في المعقول من معنى الطلب وليس يرجع إلى اللغة في المعقول من الأمور وأما قولهم إن اسم الأسد لا يعتبر في كونه اسما للإرادة فان أرادوا به أن الواضع لهذا الاسم وضعه للاسد فصار اسما له من دون أن يريد أن نسميه بذلك فذلك باطل بل نعلم انه قد أراد ذلك وإن أرادوا أنا نحن نكون مستعملين لاسم الأسد في الأسد من دون أن نريد ذلك فباطل أيضا لأنه لا بد من أن نريد ذلك وإن أرادوا أنه لا يكون اسما له في أصل الوضع بأن نريد نحن بأن يكون موضوعا له فصحيح لأن وضع الواضع الأسماء للمعاني لا يقف على إرادتنا ولذلك لا يكون الأمر واقعا على الصيغة في أصل الوضع بارادتنا على ان ذلك خارج عما نحن بسبيله لأن الذي نحن بسبيله هو هل صيغة الأمر تستحق الوصف بأنها أمر وإن لم يكن قد أراد بها الفعل أم لا فبوزن هذا أن يقال إن جسم الأسد يستحق أن يوصف بأنه أسد وإن لم تقصد بجسمه كثيرا من الأشياء
ومنها قولهم إن الانسان قد يأمر عبده بالفعل وهو يكرهه منه إذا كان قصده أن يعرف أصدقاءه عصيانه فبان أن الصيغة تكون امرا من دون إرادة والجواب أنا لا نسلم أنه أمر كما لا نسلم أنه طالب منه الفعل في نفسه وإنما يقال إنه موهم للغلام أنه طالب منه الفعل وآمر له به
ومنها قولهم إن الله سبحانه قد أمر أهل الجنة بقوله كلوا واشربوا ولم يرد ذلك منهم والجواب أن أصحابنا يقولون قد أراد ذلك منهم لأن في علمهم بارادته ذلك منهم زيادة مسرة ولا يمتنع أن يكون ذلك
إطلاقا وليس بأمر كما أن قوله لأهل النار اخسئوا وليس بأمر كما نقول لمن نذمه اخسأ
ومنها قولهم إن الله أمر إبراهيم بذبح إسماعيل وما أراد من الذبح فقد وصفت صيغة الأمر بأنها أمر مع أن فاعلها لم يرد الفعل والجواب أن ما أمر به قد أراده والذي أمر به هو مقدمات الذبح كالاضجاع وأخذ المدية أو أمره بالذبح نفسه وقد فعله إبراهيم عليه السلام لكن الله سبحانه كان يلحم ما يفريه إبراهيم شيئا فشيئا هذا إن ثبت أن إبراهيم كان قد رأى في المنام صيغة الأمر وقول إسماعيل افعل ما تؤمر يحتمل ما يؤمر في المستقبل
فإد ثبت ذلك حددنا الأمر بأنه قول يقتضي استدعاء الفعل بنفسه لا على حجة التذلل وقد دخل في ذلك قولنا افعل وقولنا ليفعل ولا يلزم عليه أن يكون الخبر عن الوجوب أمرا لأنه ليس يستدعي الفعل بنفسه لكن بواسطة تصريحه بالايجاب وكذلك قول القائل أريد منك أن تفعل هو يقتضي بنفسه إثبات إرادته للفعل وبتوسطها يقتضي البعث على الفعل وكذلك النهي عن جميع أضداد الشيء ليس يستدعي فعل ذلك الشيء بنفسه وإنما يقتضي ذلك بتوسط اقتضائه قبح تلك الأضداد واستحالة انفكاك المكلف منها إلا إلى ذلك الشيء وقد دخل في قولنا يقتضي استدعاء الفعل الارادة والغرض لأنا قد بينا أنهما داخلان في الاستدعاء والطلب والله أعلم
باب في أن قولنا افعل ليس بمشترك على سبيل الحقيقة بين فائدتين
اعلم أن من الذاهبين إلى أن لفظ العموم مشترك بين الاستغراق والبعض من جعل لفظة افعل مشتركة بين استدعاء الفعل وبين التهديد الذي هواستدعاء لترك الفعل وبين الاباحة وبين اقتضاء الايجاب وبين اقتضاء الندب جعلوها حقيقة في كل ذلك وكذلك قالوا في قول القائل لا تفعل إنه مشترك بين النهي وبين التهديد على الترك وعند جمهور الناس أن لفظة افعل حقيقتها في الطلب والأمر ومجازها في غيره وأن لفظة لا تفعل حقيقة في النهي مجاز في غيره والدليل على ذلك أنه لو كان قول القائل لغيره افعل حقيقة في أن يفعل وحقيقة في التهديد المقتضي أن لا يفعل لكان اقتضاؤه لكل واحد من هذين على سواء لا ترجيح لأحدهما على الآخر ولو كان كذلك لما سبق إلى أفها منا عند سماعها من دون قرينة أن المتكلم بها يطلب الفعل ويدعو إليه كما أنه لما كان اسم اللون مشتركا بين السواد والبياض لم يسبق عند سماع هذه اللفظة من دون قرينة السواد دون البياض ومعلوم أنا إذا سمعنا قائلا يقول لغيره افعل وعلمنا تجرد هذا القول عن كل قرينة فان الأسبق إلى أفهامنا أنه طالب للفعل لا مانع منه كما أنا إذا سمعناه يقول رأيت حمارا فانه يسبق إلى أفهامنا البهيمة دون الأبله وأيضا فان قولنا افعل في أنه في معنى الاثبات جار مجرى قولنا زيد فاعل فكما أن قولنا زيد فاعل حقيقة في كونه فاعلا وإن جاز ان يستعمل على انه غير فاعل لأن الانسان قد يقول زيد فاعل على طريق الاستهزاء أي أنه على الضد من هذه الحال فكذلك قولنا افعل يجب كونه حقيقة إذا طلب به الفعل ولا يكون حقيقة في نفي الفعل كما لم يكن قولنا زيد فاعل حقيقة في نفي كونه فاعلا إذ كل واحد منهما إثبات ونحن نستوفي الكلام في شبههم عند الكلام في العموم
باب في أن لفظة افعل تقتضي الوجوب
اختلف الناس في ذلك فذهب الفقهاء وجماعة من المتكلمين وأحد قولي أبي علي إلى أنها حقيقة في الوجوب وقال قوم إنها حقيقة في الندب وقال آخرون إنها حقيقة في الاباحة وقال أبو هاشم إنها تقتضي الارادة فإذا قال القائل لغيره افعل أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل فان كان القائل لغيره افعل حكيما وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنة يستحق لأجلها المدح إذا كان المقول له في دار التكليف وجاز أن يكون واجبا وجاز أن لا يكون واجبا بل يكون ندبا فإذا لم يدل الدلالة على وجوب الفعل وجب نفيه والاقتصار على المتحقق وهو كون الفعل ندبا يستحق فاعله المدح
والدليل على أن لفظة افعل حقيقة في الوجوب أنها تقتضي أن يفعل المأمور الفعل لا محالة وهذا هو معنى الوجوب فان قيل لم زعمتم أولا ان قول القائل افعل يقتضي أن يفعل وما أنكرتم أنه يقتضي الارادة قيل ليس يخلو من قال إنه يفيد الارادة إما أن يريد بذلك أنه يقتضي أن يفعل المأمور الفعل ومن حيث كان طلبا له وبعثا عليه يدل على الارادة من حيث كان الحكيم لا يبعث على ما لا يريده بل يكرهه وإما أن يريد أنه موضوع للإرادة كما أن قول القائل لغيره أريد منك أن تفعل موضوع للارادة ابتداء فان قال بالأول فهو قولنا لأنه قد سلم أنه موضوع لأن يفعل المأمور الفعل وقال إنه يقتضي الارادة تبعا لذلك وهذا مذهبنا وإن أراد الثاني بطل من وجوه
منها أن في صريح قولنا افعل ذكر للفعلية وليس في صريحه ذكر للارادة فلم يجز كونه موضوعا للارادة غير موضوع لأن يفعل كما أن قولنا زيد فاعل موضوع لكونه فاعلا وليس بموضوع لإرادة الاخبار عن ذلك وقد قيل إنه موضوع لارادة الاخبار عن ذلك وهذا باطل لأنه إن كان موضوعا لارادة الاخبار عنه فما الاخبار عن ذلك إن لم يكن قولنا زيد فاعل إخبارا عنه
ومنها أنه إن كان قولنا افعل موضوعا ابتداء للإرادة وجب أن يكون خبرا عنها وفي ذلك دخول الصدق والكذب فيه حتى يحسن أن يصدق من قال
ذلك أو يكذبه كما يحسن أن يقال ذلك لمن قال لغيره أريد أن تفعل إذا كانت اللفظة قد وضعت ابتداء لحصول هذه الصفة ولا يلزمنا دخول الصدق والكذب على التمني والنداء أما التمني فلانه ليس بخبر على الحقيقة لأنه غير موضوع لكون التمني متحسرا كما وضع له قول القائل أنا متحسر ومتأسف على كذا وكذا وإنما يفيد ذلك من حيث علمنا أن الداعي للانسان إلى ان يقول ليت كان زيد عندنا هو كونه متأسفا على فوات كونه عنده وأما النداء فهو أن قولنا يا زيد إنما يفيد إذا أضمر فيه معنى الأمر على ما تقدم والصدق والكذب لا يدخلان الأمر ول كان معناه انادي زيدا لما دخله الصدق والكذب لأن ذلك مضمر غير مظهر
ومنهاأنه لو كان قولنا إفعل موضوعا للارادة لاحتجنا إلى أن نريد تعليق ذلك بالارادة كما أن قولنا أريد منك أن تفعل لا يتعلق عند أصحابنا بكونه مريدا إلا أن نريد ذلك
فان قالوا إن قولكم إن لفظة افعل تقتضي أن يفعل لا يتصور إلا على ان يكون إخبارا عن أنه سيفعل أو يفيد إرادة الفعل قيل لهم هذا كلام من لا يتصور في أقسام الكلام إلا الخبر ونحن قد بينا أن الأمر قسم من أقسام الكلام غير الخبر لا يدخله الصدق والكذب وقد بين أهل اللغة ذلك وإذا رجعنا إلى أنفسنا عقلنا فرق ما بين طلب الشيء والإعلام عنه والإخبار وأنه قد يكون لنا غرض في طلب الشيء من الغير ويكون لنا غرض في أن نعلم الغير به فلم يمتنع أن يضع أهل اللغة لفظتين بحسب هذين الغرضين ويكون كل واحدة من اللفظتين وصلة إلى ذلك الغرض ولا يكون إخبارا عنه ألا ترى أن الخبر وهو قولنا زيد في الدار ليس هو إخبارا عن إرادتنا الإخبار عن كونه في الدار بل هو وصلة إلى بلوغ غرضنا من إعلام غيرنا كون زيد في الدار فكذلك قولنا افعل هو وصلة إلى غرضنا من طلب الفعل من غيرنا وليس هو إخبار عن غرضنا وأيضا فكيف عقلتم تعلق الارادة بالفعل أن
يحدث فقلتم إن لفظة افعل موضوعة لارادة أن يفعل ولم يعقلوا قولنا إنها موضوعة لأن نفعل اعقلوا عنا في الصيغة ما عقلتموه عن أنفسكم في الارادة فان قالوا إرادة أن يفعل معناه أنها إرادة للحدوث فقولوا إن الأمر متعلق بالحدوث قيل كذلك نقول إن الأمر طلب للحدوث وليس من مذهبكم أن الارادة متعلقة بالحدوث كما ليس من مذهبكم أن العلم متعلق بالحدوث وإنما تقولون إن الارادة متعلقة بالفعل على وجه الحدوث وهو معنى قولكم إرادة للفعل أن يحدث فان قالوا فلم إذا كانت لفظة افعل تقتضي أن يفعل المأمور الفعل كانت تقتضي أن يفعله لا محالة قيل لأن لا يفعل المأمور الفعل هو نقيض أن يفعل واللفظة إذا وضعت لشيء فانها تمنع من نقيضه ألا ترى أن قول القائل زيد في الدار لما أفاد حصوله فيها منع من نقيضه وهو أن لا يكون فيها ولم يجز أن يكون قوله زيد في الدار ومعناه الأولى أن يكون فيها فكذلك لفظة افعل وهذا هو الوجوب
ويدل على أن لفظة افعل تمنع من الإخلال بالفعل أن اهل اللغة يقولون أمرتك فعصيتني وقلت لك افعل فعصيتني وقال الله عز و جل أفعصيت أمري وقال الشاعر
... أمرتك امرا حازما فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما فعقب المعصية ...
على الأمر بلفظ الفاء فدل على أن المعصية إنما لزمت المامور لأجل إخلاله
بما أمر به وأن لتقدم الأمر في استحقاق هذا الاسم تأثيرا كما أن قولهم إذا دخل زيد الدار فأعطه درهما يفيد أن لتقدم الدخول تأثيرا في استحقاق العطية ومعلوم أن الانسان إنما يكون عاصيا للآمر والأمر إذا أقدم على ما يحظره الآمر ويمنع منه ألا ترى أن الله لو أوجب علينا فعلا فلم نفعله لكنا عصاة ولو ندبنا إليه فقال الأولى أن تفعلوه ولكم أن لا تفعلوه فلم نفعله لم نكن عصاة ولهذا يوصف تارك الواجب بأنه عاصي لله ولا يوصف تارك النوافل بذلك ولا فصل بينهما إلا لأن إيجابه الفعل علينا يحظر الاخلال به وترغيبه إيانا فيه من غير إيجاب لا يحظر علينا تركه فلذلك لم نكن بتركه عاصين وأيضا فان العاصي للقول مقدم على مخالفته وترك موافقته وليس تخلو مخالفته إما أن تكون بالاقدام على ما يمنع منه الآمر فقط أو قد يثبت بالاقدام على ما لا يتعرض له الآمر بمنع ولا إيجاب وليس يجوز هذا الأخير لأنا لو كنا عصاة للامر بفعل ما لم يمنع منه لوجب إذا أمرنا الله سبحانه بالصلاة غدا فتصدقنا اليوم أن نكون عصاة لذلك الأمر بصدقتنا اليوم فبان أن مخالفة الآمر إنما تثبت بالاقدام على ما يمنع منه فاذا كان تارك ما أمر به عاصيا للامر والعاصي للامر هو المقدم على مخالفة مقتضاه والمقدم على مخالفة مقتضاه مقدم على ما يحظره الآمر ويمنع منه ثبت أن ترك المأمور به يمنع منه الآمر ويحظره وهذا هو معنى الوجوب
إن قيل أليس المشير قد يقول لمن أشار عليه قد أشرت عليك فعصيتني ولم يدل ذلك على الإيجاب قيل إنا نقول في لفظة افعل إنها دعاء إلى الفعل ومنع من الاخلال به وأن ظاهرها يقتضي أن المستعمل لها استعملها في هذا المعنى وهذه حالة المشير إذا قال لغيره افعل كيت وكيت فهو الرأي والحزم لأنه إنما يدعوه الى فعل الحزم وترك الإخلال به والمستشير ايضا إنما يطلب منه أن يشير عليه بالرأي الذي لا معدل عنه يبين ما قلناه أن المشير لو قال له الأولى أن تفعل كذا وإن تركته لم يكن به بأس فتركه لا يقال إنه قد عصاه كيف يكون قد عصاه وقد رخص له في الترك وإنما يكون عاصيا له إذا قال له الرأي أن تفعل كذا وهو الأولى وافعل لأن الأولى في الرأي هو الأحزم والأحوط وما هذه سبيله فالمشير يوجبه ولا يرخص في تركه وان لم يلزم المستشير قبول إيجابه ويلزمنا قبول إيجاب الله ورسوله ص
فان قيل إن الذي ذكرتموه يدل على أن الأمر يمنع من الإخلال بالمأمور به وليس هذا من قولكم لأن الأمر هو قول القائل لغيره مع الإرادة والإرادة لا تقتضي الوجوب والجواب أنا فرضنا الكلام في لفظة افعل لأنهم قد يقولون قلت لك أقسم في هذا البلد فعصيتني وظاهر لفظة افعل للوجوب عندنا ولو فرضنا الكلام في قولهم أمرتك لم يضرنا لأن الأمر هو قول القائل افعل مع الارادة والرتبة وليس يجب إذا كانت الارادة لا تقتضي الوجوب أن لا تقتضيه الصيغة التي هي افعل
ومما يدل على أن الأمر على الوجوب أن العبد إذا لم يفعل ما أمره به سيده اقتصر العقلاء من أهل اللغة في تعليل حسن ذمه على أن يقولوا أمره سيده بكذا فلم يفعله فدل كون ذلك علة في حسن ذمه على أن تركه لما أمره به ترك لواجب إن قيل إنما ذموه لأنهم علموا من سيده أنه كاره من عبده ترك ما أمره به قيل اقتصارهم على التعليل الذي ذكرناه دليل على أنه استحق الذم لما ذكروه من العلة لا غير فان قيل إن هذا التعليل مشروط بأن يكون السيد كارها للترك كما يشرطونه بكون ما أمر به سيده حسنا غير قبيح قيل ليس يجب إذا شرطنا هذا التعليل حسن المأمور به إن شرط شرطا آخر لم يدل على اشتراطه دلالة على أن العقلاء يفضلون ما أمره به فيقولون أمره بكذا فلم يفعل ولو كان ما فضلوه قبيحا لما ذموه ولو أنهم قالوا أمره فلم يفعل لقال العقلاء بماذا أمره لعله أمره بظلم غيره وإنا يمسكون عن ذلك إذا فضلوا ما أمره به فان قيل أليس لو قال له أريد منك أن تفعل كذا فلم يفعله لامه العقلاء قيل لا نسلم ذلك ولو ثبت لكان عندنا وعندكم مشروطا بكراهية السيد الترك وعلمهم بذلك من حاله وليس يجب إذا شرطنا ذلك أن يشرط غيره إلا لدلالة إن قيل إنما ذموه لأجل إخلاله بما أمره به سيده لأن الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده وامتثال أوامره أو لأنه لا يأمره إلا بما فيه منفعته ودفع مضرة عنه والعبد يلزمه إيصال المنافع إلى سيده ودفع المضار عنه ولأن ذلك دلالة على أن السيد قد كره منه ترك ما
أمره به ولهذا لو أمره السيد بفعل يخص العبد لما وجب عليه والجواب أن الشريعة إنما ألزمت العبد طاعة سيده إذا أوجب السيد عليه طاعته ولم تلزمه لأجل سيده فعلا لم يلزمه إياه سيده ألا ترى أن سيده لو قال له الأولى أن تفعل كذا ولك أن لا تفعله لما ألزمته الشريعة فعله والأمر عند المخالف يجري مجرى هذا القول فينبغي أن لا يجب به على العبد شيء ولا يجب على العبد إيصال النفع إلى سيده ولا دفع المضار عنه إلا إذا أوجبه عليه سيده ولم يرخص له في تركه ألا ترى أنه لو قال له الأولى أن تفعل ذلك ويجوز أن لا تفعله لجاز له أن لا يفعله وكذلك لو علم أن غيره يقوم مقامه في دفع المضرة عنه وأما قول السائل إن كون السيد منتفعا بما أمره به دلالة على أنه قد كره تركه فلا يصح لأنه ليس يجب إذا انتفع بشيء أن يكره من عبده تركه لجواز أن يكون إنما يكره من غير ذلك العبد تركه وإنما يعلم أنه قد كره من ذلك العبد تركه إذا دله على ذلك والأمر عند السائل ليس بدليل على الإيجاب ولا على هذه الكراهة فلم يلزم العبد ذلك الفعل فأما قول السائل إن السيد لو أمر العبد بفعل يخص العبد لم يجب عليه لما لم ينتفع السيد به فغير مسلم أنه لا يجب عليه وغير مسلم أنه لا ينتفع السيد بذلك لأنه إذا أمر العبد بمنفعة أو بدفع مضرة عن نفسه فان ذلك يعود بصلاح ماله فمن هذه الجهة يكون للسيد فيه منفعة أو دفع مضرة
دليل آخر قول القائل افعل يقتضي إيقاع الفعل وليس لجواز تركه لفظة فيجب المنع من تركه وإذا لم يجز تركه فقد وجب ولمعترض أن يعترض ذلك فيقول إن لفظة افعل تقتضي إيقاع الفعل غير أنا لا نسلم أنه يقتضيه على سبيل الإيجاب وإذا لم نسلم لكم ذلك لم يثبت الوجوب إذا لم يدل دليل على جواز الإخلال بالفعل لأنه إنما يثبت الوجود إذا فقدنا دليل جواز الترك إذ أثبتت أن لفظة افعل تقتضي وجوب الفعل وفي هذا وقع الخلاف ولو ثبت ذلك ما احتاج المستدل أن يقول إنه ليس لجواز الترك لفظ ألا ترى أن فقد دليل التخصيص لا يكفي في العلم شمول العموم إلا بعد
أن يبين أن لفظ العموم يقتضي الشمول
دليل آخر لفظة افعل تقتضي قصر المأمور على الفعل وحصره عليه وذلك يمنع من جواز الإخلال به ولقائل أن يقول إن أردتم بقولكم إنه يقتضي قصر المأمور على الفعل أنه يقتضي إيجابه ففيه النزاع وإن أردتم أنه بعث عليه وليس فيه إباحة الإخلال به فهو الدليل المتقدم
دليل آخر لو اقتضى الأمر الندب كان معناه افعل إن شئت وليس في الأمر ذكر هذا الشرط ولقائل أن يقول والإيجاب غير مذكور في اللفظ فلا يجوز أن يقتضيه فان قيل إن معنى الإيجاب في لفظ الأمر قيل لكم سوى ذلك وقد تم غرضكم وأيضا فالقائلون بالندب لا يقولون إن المكلف قد قيل له افعل إن شئت لأن هذا يقتضي التخير وليست هذه حالة الندب لأن الندب الأولى أن يفعل فالمكلف قد ندب إلى الفعل وندب إلى أن يشاءه ويريده
دليل آخر قول القائل افعل إما أن يقتضي إرادة الفعل وإما أن يقتضي المنع من الفعل أو التوقف عنه أو التخيير بينه وبين الإخلال به على سواء أو على أن يكون الأولى أن يفعل فان خير بينه وبين الإخلال به أو يقتضي أن يفعل لا محالة وقد تقدم بطلان القول بأنه يقتضي الإرادة ومن المحال أن يكون قوله افعل معناه لا تفعل لأنه نقيض فائدة اللفظ أو أن يكون معناه توقف لأن قوله افعل بعث على الفعل فهو نقيض التوقف ولا يجوز أن يقتضي التخيير بين الفعل وتركه على سواء وعلى أن يكون الأولى أن يفعل لأنه ليس للتخيير ذكر في اللفظ ولا للإخلال بالفعل ذكر وإنما اللفظ يتعلق بالفعل دون تركه ولقائل أن يقول قد أخللتم بقسم آخر وهو أن يكون قولنا افعل يفيد استدعاء الفعل والبعث عليه ولا يتعرض للإخلال به بمنع ولا إباحة وليس لكم أن تقولوا لما لم يكن في اللفظ ذكر للتخيير ولا للترك وجب نفي التخيير وإثبات الوجوب بأولى من أن تقولوا إنه لما لم
يكن في اللفظ ذكر للمنع من الإخلال بالفعل وجب نفي الوجوب وفي نفيه إثبات الندب فان قلتم لفظة افعل يمنع من الإخلال بالفعل قيل لكم بينوا ذلك وقد تم غرضكم من غيرحاجة منكم إلى هذه القسمة
دليل آخر أجمع المسلمون على أن الله عز و جل أوجب علينا الصلاة بقوله أقيموا الصلاة وأجمعوا على أن ذلك ليس بمجاز فلو لم يكن الأمر للوجوب بل كان للإدارة أو الندب لكان المستعمل له في الوجوب قد أراد به الفعل وكره به تركه وفي ذلك استعماله فيما لم يوضع له لأن معنى استعمال الأمر في الوجوب هو أنه كره تركه ولو أن أهل اللغة اضطروا من القائل لغيره افعل إلى أنه قد كره منه ترك الفعل لما سبق إلى أنه يجوز بالأمر ولقائل أن يقول أنا من المسلمين ولا أقول إن الله أوجب الصلاة بقوله أقيموا الصلاة وإنما استعمل ذلك فيما وضع له وهو إرادة الصلاة وإنما كره تركها بدليل الوجوب من وعيد وغيره فكيف يمكنكم ادعاء الاجماع مع خلافي لكم مع طائفتي في ذلك ولا أسلم قولكم إن أهل اللغة لو علموا أن القائل لغيره افعل قد كره منه ترك الفعل بالأمر ما نسبوه إلى أنه مستعمل في غير ما وضعت له
دليل آخر قول القائل لا تفعل يقتضي الامتناع من الفعل لا محالة ويمنع من فعله فكان قوله افعل يقتضي أن يفعل ولا يرخص له في تركه والمخالف يقول إني لا أستفيد تحريم المنهي عنه من لفظ النهي إلا بتوسط الكراهة إما لأن لفظ النهي موضوع لها وإما لأن الناهي لا ينهي إلا عما يكره والحكيم لا يكره من غيره إلا القبيح فان ثبت أن الناهي ينهي عما لا يكره لم يدل مجرد النهي على تحريم المنهي عنه
دليل آخر الإيجاب معقول لأهل اللغة وتمسهم الحاجة إلى العبارة عنه فلو
لم يفده الأمر لم يكن له لفظ ولقائل أن يقول وكون الفعل على صفة زائدة على حسنه أو كون الفعل مرارا معقول لهم والحاجة تمس إلى العبارة عنه فلو لم يكن الأمر موضوعا له لم يكن له لفظ فان قالوا الأمر موضوع لذلك قيل وغير الأمر موضوع للإيجاب وهو قول القائل ألزمت وأوجبت وحتمت
دليل آخر الأمر بالشيء نهي عن صده والإخلال به والنهي يقتضي حظر المنهي عنه فوجب حظر الإخلال بالمأمور به وفي ذلك وجوب المأمور به ولقائل أن يقول ما تريدون بقولكم إن الأمر بالشيء نهي عن الإخلال به فان قالوا إن صورته صورة المنهي كان الحس يشهد بخلاف ذلك وإن قالوا إنه نهي في المعنى قيل لهم ما ذلك المعنى فان قالوا هو أن الأمر يقتضي أن يفعل المأمور به لا محالة قيل لهم بينوا ذلك وهو الدليل الأول وإن قالوا هو أن الأمر بالشيء يقتضي الإرادة والإرادة للشيء كراهة ضده أو لا بد من أن تقترن بها كراهة الضد إما من جهة الصحة أو من جهة الحكمة ومن كره أضداد الشيء فقد ألزم ذلك الشيء قيل لكم هذا باطل بالنوافل لأن الله سبحانه قد أرادها منا ولذلك نكون مطيعين له بفعلها وليس بكاره لتركها واضدادها فان قالوا معنى ذلك أن الأمر يقتضي إرادة فعل المأمور به على جهة الإيجاب قيل لا معنى لكون الحي مريدا للفعل على جهة الإيجاب إلا أنه أراده وكره تركه وقد تقدم إبطال ذلك ولو كانت الإرادة تتناول الشيء على جهة الإيجاب لوجب عليكم أن تدلوا على أن الأمر يقتضي هذه الإرادة حتى يتم دليلكم ومتى دللتم على ذلك تم غرضكم قيل القول إن النهي إذا اقتضى قبح أضداد الشيء فقد وجب ذلك الشيء وإن قالوا معنى ذلك أن لفظة الأمر تدعو إلى فعل المأمور به وتحظر الإخلال به قيل لهم بينوا ذلك وقد تم غرضكم ونحن قد بينا ذلك من قبل
دليل آخر الأمر إذا حمل على الوجوب كان أحوط والأخذ بالأحوط
واجب ألا ترى أنا إذا حملناه على الوجوب لم يخل المأمور به إما أن يكون واجبا أو ندبا فان كان ندبا لم يضرنا فعله بل ينفعنا وإن كان واجبا أمنا الضرر بفعله وإذا حملناه على الندب لم نأمن أن يكون واجبا فنستضر تركه ولقائل أن يقول أنا قد علمت بدلالة لغوية أن الأمر ما وضع للوجوب وعلمت أن الحكيم لا يجوز أن يجرده عن قرينة إلا والمأمور به غير واجب فأنا إذا حملته على الندب أمنت الضرر ويقول أيضا ليس يخلو المستدل إما أن يكون عالما بأن الأمر وضع للوجوب أو عالما بأنه وضع للندب والإرادة أو عالما بأنه مشترك بينهما أو شاكا في موضوعه فان كان عالما بالوجوب فقد وجب عليه حمله على الوجوب لعلمه بأنه موضوع له لا لأنه لا يأمن أن يكون قد عني به الوجوب وينبغي أن يدلنا على أنه موضوع للوجوب وإن كان عالما بانه للندب فهو آمن إذا تجرد أن يكون الحكيم قد عني به الوجوب وإن كان عالما بأنه مشترك بين الوجوب والندب فليس ذلك من قولهم ويلزمهم إن كان كذلك أن يجعلوا المكلف مخيرا بين حمله إياه على الوجوب أو على الندب كما يقوله بعض الناس في الاسم المشترك أو يقول إن الحكيم للخلية من قرينة كما يقوله آخرون في الاسم المشترك وأن كان شاكا في موضوع الأمر فالاحتياط يقتضيه أن يفحص عن موضوعه حتى إذا عرفه حمل خطاب الحكيم عليه ويكون آمنا من الضرر على أن كلا منا إنما هو في موضوع الأمر ما هو في اللغة وإيجاب حمله على الوجوب لأجل الاحتياط لا يدل على أنه موضوع له في اللغة على أن من حمل المأمور به على الوجوب عدولا عن الاحتياط من وجوه لأنه لا يأمن إذا اعتقد وجوبه أن يكون ندبا فيكون اعتقاد وجوبه جهلا وتكون نية الوجوب قبيحة وكراهته لأضداده قبيحة وأما وجوب إعادة الصلوات الخمس إذا ترك الإنسان واحدة منها لا يدري ما هي فلان الواجب غير متميز من غيره وليس كذلك موضوع الأمر لأنه يمكن أن يعرف ما موضوعه ويعلم أن الحكيم يجب في حكمته أن يعينه دون غيره وعلى أن العلم على اليقين غير مستمر وجوبه ألا
ترى أن من يعتاد السهو في صلاته إذا سها فاليقين أن يعيد صلاته وليس اليقين أن يبني على الأقل ولا أن يتحرى ومع ذلك لم تجب عليه الإعادة وربما حققوا شبهتهم بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والجواب أن المخالف يقول إذا حملت الأمر على الندب فقد عدلت عما يريبني إلى الثقة واليقين ولا ريب في ذلك
دليل آخر الوجوب أعم فوائد الأمر لأنه يدخل تحته الحسن والمندوب إليه واللفظ يجب حمله على أتم فوائده ولقائل أن يقول ولم يجب حمله على أتم فوائده فان قالوا لمكان الاحتياط كان الكلام عليهم ما تقدم وإن قالوا ذلك قياسا على العموم قيل لهم وما العلة الجامعة بينهما ويقال لهم إن العموم إنما حمل على الاستغراق ليس لأنه أعم فوائده لكن لعلمنا بأنه موضوع للاستغراق فقط فينبغي أن تبينوا أن موضوع الأمر للوجوب حتى يتم لكم غرضكم على أن الندب على التحقيق ليس بداخل تحت الوجوب لأن المندوب إليه هو الذي يستحق المدح بفعله ولا يستحق الذم بالاخلال به وليس يجمع كلا الأمرين للواجب
وقد استدل من جهة الشرع على أن أوامر الله سبحانه وأوامر نبيه صلى الله عليه و سلم على الوجوب بوجوه منها قول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره الأية فحذر من مخالفة أمر نبيه صلى الله عليه و سلم وتوعد عليه ومخالفة أمره هو الإخلال بما أمر به فوجب كون الإخلال بما أمر به محظورا وهذا هو وجوب فعل ما أمر به فاذا ثبت ذلك في أوامر النبي صلى الله عليه و سلم وجب مثله في أوامر الله سبحانه لأن كل من قال إن الشرع قد دل على أن أوامر النبي صلى الله عليه على الوجوب قال إن أوامر الله سبحانه على الوجوب وإنما قلنا إنه عز و جل حذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه و سلم لأنه قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فحث
بذلك على الرجوع إلى أقواله ثم عقب ذلك بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره فعلمنا أنه بعث بذلك على التزام ما كان دعا إليه من الرجوع إلى أمر النبي صلى الله عليه و سلم فلو ثبت أن الهاء في أمره راجعة إلى اسم الله لدل على وجوب الرجوع إلى أوامر الله سبحانه وفي ذلك وجوب مأمورها وثبت مثله في أوامر النبي صلى الله عليه و سلم لأن أحدا ما فرق بينهما وإنما قلنا إن مخالفة أمره هو الإخلال بمأموره لأن المخالفة ضد الموافقة وموافقة القول هو فعل ما يطابقه ومعلوم أن موافقة قول القائل لغيره افعل هو أن يفعل فيجب أن تكون مخالفته هو أن لا يفعل إن قيل مخالفة القول هو الإقدام على ما يحظره القول ويمنع منه فيجب أن تبينوا أن الإخلال بالمأمور به يحظره القول حتى يدخل في الاية وإذا بينتم ذلك فقد تم غرضكم من أن الأمر يقتضي الوجوب قيل ليس نحتاج في أن نعلم أن الإخلال بالمأمور به مخالفة الأمر إلى ما ذكرتم بل يمكننا أن نعلم ذلك بما قلناه من أن المخالفة ضد الموافقة وموافقة الأمر هو فعل المأمور به وإذا كان كذلك لم نكن قد بينا الدلالة على موضع الخلاف إن قيل مخالفة الأمر هو الرد على فاعله واتهامه في القول وموافقته هو الثقة به وترك الرد عليه قيل موافقة القول هو الإقدام على مطابقته ومخالفته هو ترك مطابقته والرد على النبي صلى الله عليه و سلم وأله وترك الثقة به هو مخالفة للدليل الموجب لاعتقاد الثقة به وليس هو مخالفة للأمر لأن الأمر لا يدل على أنه غير متهم في أقواله بل العلم بذلك يسبق الاستدلال بأمره وكذلك الثقة به هو موافقة دليل الثقة به لا الأمر بالفعل إن قيل لو كان الإخلال بالمأمور به مخالفة للأمر لكنا إذا لم نفعل النوافل المأمور بها مخالفين لأمر الله وفي ذلك كوننا مخالفين لله سبحانه إذا أخللنا بالنافلة قيل إنما لم نكن مخالفين للامر بالنافلة لأن الأمر بالنافلة في تعذر قول النبي صلى الله عليه و سلم الأولى أن تفعلوا كذا وكذا
ويجوز أن لا تفعلوه وهذه زيادات لا ينبيء عنها قوله افعل وهو صريح الأمر وإذا كان كذلك لم نكن مخالفين للامر بالنوافل لأن في مضمونها جواز الترك فان قيل فيجب أن تعلموا أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم ليس في هذا التقدير حتى تعلموا أن الإخلال بالمأمور به مخالفة له وإذا علمتم ذلك فقد علمتم أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب قبل الاستدلال بهذه الآية قيل نحن نعلم ذلك لعلمنا أن قول القائل افعل يقتضي إيقاع الفعل وأنه لا دليل في صريحه يدل على أنه في تقدير قول القائل الأولى أن تفعل ويجوز أن لا تفعل وليس يجب إذا علمنا ذلك أن نعلم أنه على الوجوب لأنه لا يجب أن يكون على الوجوب إذا لم يكن في صريحه ما يدل على التخيير ونفي الوجوب إلا بعد أن يثبت أن صريحه يدل على الوجوب على ما ذكرناه من قبل فان قيل قد علمنا أن من قال إن ظاهر الأمر للندب لا يلزمه الوعيد فعلمنا أن قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره المراد به الرد على النبي صلى الله عليه و سلم والجواب أن الله سبحانه إنما حذر من لحوق العذاب ممن خالف أمر النبي صلى الله عليه و سلم وليس في ذلك تحقق لنزول العذاب وإذا كان كذلك كان من حمل أمر النبي صلى الله عليه و سلم على الندب مخطئا بلأن ذلك ليس من مسائل الاجتهاد وكل ما كان خطأ فانه يجوز أن يكون كثيرا وكلما جاز أن يكون كثيرا لم يؤمن لحوق العذاب بفاعله فثبت التحذير في ترك المأمور به ولو كان ذلك من مسائل الاجتهاد للحق ذلك الوعيد من خالف أمر النبي صلى الله عليه و سلم إذا لم يعتقد أنه على الندب وفي ذلك بوجه الوعيد
دليل آخر وهو قول الله عز و جل وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فذمهم على أنهم تركوا ما قيل لهم افعلوه ولو كان الأمر يفيد الندب لم يذمهم على ترك المأمور به كما أنه لا يجوز أن نقول إذا قيل لهم الأولى أن تفعلوه ومرخص لكم في تركه لم تذمهم على الترك وقوله عز
وجل ويل يومئذ للمكذبين كلام مبتدأ لا يمنع من كونه عز و جل ذاما لهم لأجل تركهم فعل ما قال لهم افعلوه
دليل آخر قول الله سبحانه لإبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك ليس باستفهام لكنه خارج مخرج الذم والاستبطاء لإبليس وأنه لا عذر له ولا رخصة في إخلاله بالسجود مع أمره به هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده ما منعك من دخول الدار إذا أمرتك متى لم يكن السيد مستفهما فلو لم يكن الأمر على الوجوب لم يذمه ولا استبطأه ولكان لإبليس أن يقول الذي سوغ لي ترك السجود إنك لم تلزمينه بل رخصت لي في تركه إن قيل لعله أمره بلغة أخرى والأمر فيها موضوع للوجوب لا في لغة العرب قيل الظاهر يقتضي أنه ذمه لأنه أمره أمرا مطلقا فلم يفعل لا لأنه أمره أمرا مخصوصا في لغة مخصوصة على أن طريقة من قال أن الأمر على الندب هو أنه يفيد الإرادة لا غير والإرادة لا تفيد الوجوب وهذه الطريقة لا تختلف فيها اللغات
دليل آخر وهو قوله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم والقضاء قد يكون بمعنى الفعل وحقيقة الأمر للقول فكأنه قال إذا فعل النبي صلى الله عليه و سلم أمرا فليس لأحد أن يتخير فيه وفي ذلك وجوب المصير إليه وقد قيل إن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر قوما أن يزوجوا زيد بن حارثة فأبوا فأنزل الله سبحانه هذه الآية ولقائل أن يقول إن حقيقة الأمر وإن كان في القول فإنه إذا قرن بالقضاء فقيل قضى فلان أمرا جرى مجرى أن يقول فعل فلان شيئا سيما وقد قلنا فيما تقدم إن الأمر إذا أطلق كان حقيقة في الشيء وفي القول وفي الشأن وإنما يتخصص بحسب القرائن وهذه
القرينة تدل على أن المراد به الشيء فيكون المراد بذلك إذا الزم شيئا لأن القضاء يكون بمعنى الإلزام ولا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قد كان ألزم أن يزوج زيد بن حارثة بلفظ من ألفاظ الإلزام إن ثبت أن قصة زيد هي سبب نزول الآية
دليل آخر قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت الآية فأوجب التسليم لما قضاه والقضاء هو الأمر ولقائل أن يقول إن القضاء هو الإلزام ها هنا وعلى أن المراد بقوله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت المراد به السخط وترك الرضا ولهذا قال ويسلموا تسليما فان قالوا لو كان القضاء بمعنى الإلزام لما قيل إن الله سبحانه قد قضى الطاعات كلها لأن النوافل ما ألزمها قيل ولو كان القضاء بمعنى الأمر والأمر على الوجوب لما قيل إن الله قد قضى الطاعات كلها على أن المراد بقولنا إن الله قضى النوافل أنه أخبر عنها وذلك يعم الطاعات كلها النوافل وغيرها
دليل آخر وهو قوله سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهذا لا يدل لأنه أمر وفيه الخلاف وادعاؤهم الإجماع بأن طاعة النبي صلى الله عليه و سلم واجبة لا يسلمها الخصم لأن النوافل طاعة للنبي صلى الله عليه و سلم وليست بواجبة وقوله تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم حملتم لو رجع إلى صدر الكلام لم يصح التعلق به لأن التولي ليس هو ترك المأمور به لأنه لا يوصف بذلك تارك النوافل وقوله من بعد وإن تطيعوه تهتدوا لا يدل على وجوب الطاعة لأن الاهتداء قد
يكون بفعل النافلة إذ فاعلها مهتد إلى رشده وصلاحه وقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إنما يصح التعلق به في وجوب أوامر النبي صلى الله عليه و سلم لو ثبت أن من لم يفعل مأمورها عاص للنبي صلى الله عليه و سلم وقوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون الآية لا يدل لأن وجوب الاستجابة إلى الجهاد معلوم بما تقدم وقوله تعالى وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم يدل على أن المراد بالتوالي ها هنا العدول عن الطاعة على وجه العناد لأنهم هكذا تولوا من قبل
دليل آخر وهو ما روي أن رجلا قال يا رسول الله أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال بل لعامكم فقط ولو قلت نعم لوجبت فأخبرها أن وجوبها متعلق بقوله ولقائل أن يقول إن قوله نعم ليس بأمر فيدل على ما ذكرتم والمراد بذلك لو قلت نعم هي للأبد لوجبت عليكم في كل عام ويكون الموجب لذلك إخبار الله تعالى عن وجوبها لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت وذلك أن وجوب الحج قد كان استقر ولم يعلم السائل أن تلك الحجة مسقطة للوجوب الثابت بالآية بل جوز أن لا يسقطه إلا في تلك السنة فقول النبي صلى الله عليه و سلم لو قلت نعم معناه لو قلت انه يسقط الفرض في تلك السنة فقط لوجبت لأنه كان يكون ذلك بيانا لكون الواجب الثابت بالآية ثابتا في كل سنة
دليل آخر وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولو كان الأمر بالشيء لا
يقتضي إلا كونه ندبا لم يكن في هذا الكلام فائدة لأن السواك قد كان ندبا قبل هذا الكلام ولقائل أن يقول إن هذا الوجه أمارة على انه أراد لأمرتهم على وجه يقتضي الوجوب وليس يمتنع أن يقتضي الأمر الوجوب بدلالة
دليل آخر روي أن النبي صلى الله عليه و سلم دعا أبا سعيد الخدري فلم يجبه لأنه كان في الصلاة فقال ما منعك ان تستجيب وقد سمعت قول الله سبحانه يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول الآية فلامه على ترك الاستجابة مع أن الله سبحانه أمر بها فدل على أن الأمر على الوجوب فان قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم لم يلمه ولكنه أراد أن يبين أنه لا يقبح الاستجابة للنبي صلى الله عليه و سلم إذا دعاه وهو يصلي وأن دعاء النبي صلى الله عليه و سلم مخالف لدعاء غيره والجواب أن ظاهر الكلام يقتضي اللوم وهو في معنى الإخبار عن نفي العذر وذلك لا يكون إلا والأمر على الوجوب
دليل آخر وقد استدل على ذلك بالإجماع من وجوه
منها أن الأمة اتفقت على وجوب طاعة الله ورسوله وامتثال أوامرهما طاعة لهما فكان واجبا ولقائل أن يقول المراد بطاعة الله وطاعة رسوله التصديق لهما وامتثال ما أوجبا دون ما لم يوجباه من النوافل وما ثبت من كون النوافل مأمور بها وفاعلها يكون مطيعا ولا يجب عليه لا يدل على أن المراد بوجوب طاعة الله ورسوله ما ذكرناه
ومنها أن المسلمين كانوا يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله في الأحكام ولم يسئلوا النبي صلى الله عليه و سلم عن بعض أوامره ما الذي عناه به وقد أجيب عن ذلك بأنهم إنما رجعوا إليهما لأن الأحكام تثبت بالإيجاب وبالندب والوجوب يثبت بغير الأمر مما هو في الكتاب والسنة نحو الزجر والتهديد
والوعيد والخبر عن الوجوب ولهذا فهموا وجوب الصلاة من قول الله سبحانه إن الصلواة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلفظة على تقتضي الوجوب وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يدل على وجوب الحج وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها الآية يدل على وجوب الزكاة
ومنها أن أبا بكر الصديق رضوان الله عليه استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة بقوله وءاتوا الزكاة ولم ينكر عليه أحد في هذا الاستدلال وقد أجيب عن ذلك بأن القوم لم ينكروا وجوبها وإنما أنكروا استدامة وجوبها عليهم والأمر بالزكاة لا يدل على الاستمرار فعلمنا أنه لم يتعلق بالأمر وإنه إنما احتج باقتران الزكاة إلى الصلاة وكون الصلاة مستمرا وجوبها
ومنها أن الصحابة كانت حين تسمع الأمر من الكتاب والسنة تحمله على الوجوب فدل على أنها كانت تحمل الأوامر على الوجوب كما دل رجوعها إلى أخبار الآحاد في الأحكام على أنها اعتقدت كونها حجة ألا ترى إلى إيجابها أخذ الجزية من المجوس برواية عبد الرحمان سنوا بهم سنة أهل الكتاب وإيجابهم غسل الإناء من ولوغ الكلب بقول النبي صلى الله عليه و سلم فليغسله سبعا وأوجبوا إعادة الصلاة عند ذكرها لقول النبي صلى الله عليه و سلم فليصلها إذا ذكرها إلى غير ذلك وقد أجيبوا عن ذلك بأنهم إنما صاروا إلى شيء سوى الأمر في وجوب هذه العبادات لأنهم كما اعتقدوا الوجوب عند هذه الأوامر فإنهم لم يعتقدوه عند غيرها نحو قول الله سبحانه وأشهدوا إذا تبايعتم فكاتبوهم إن علمتم فيهم
خيرا فانكحوا ما طاب لكم من النساء وإذا حللتم فاصطادوا إلى غير ذلك وليس لأحد أن يقول إنما لم يعتقدوا الوجوب عند هذه الأوامر لدليل بأولى من أن تقولوا إنما قالوا بالوجوب عند تلك الأوامر لدليل لا لظاهر الأمر
واحتج أصحابنا القائلون بأن الأمر لا يقتضي الوجوب بما هذا معناه لو اقتضي الأمر الوجوب لاقتضائه إما بلفظه أو بفائدته التي هي الإرادة أو بشرطه الذي هو الرتبة وليس شيء من ذلك يقتضي الوجوب فالأمر إذا لا يقتضي الوجوب لكن الإرادة تقتضي الندب على بعض الوجوه فصح أن الأمر يقتضي الندب
واستدلوا على أن صيغة الأمر لا تقتضي الوجوب بأن الوجوب ليس في لفظها وبأن صيغتها إنما تفيد الإرادة فقط واستدلوا على ذلك بوجوه
منها أنه لا فرق بين قول القائل افعل وبين قوله أريد منك أن تفعل يفهم أهل اللغة من أحدهما ما يفهمونه من الآخر ويستعمل أحدهما مكان الآخر فجرى مجرى إدراك البصر ورؤية البصر في أن المفهوم من أحدهما هو المفهوم الآخر فلما أفاد قولنا أريد منك أن تفعل الإرادة فقط دون كراهة ضد الفعل ودون إيجاب الفعل وجب مثله في قولنا أفعل
ومنها أن أهل اللغة قالوا إن قول القائل لغيره افعل يكون أمرا إذا كان فوق المقول له في الرتبة وسؤالا إذا كان دونه في الرتبة فلم يفرقوا بينهما إلا بالرتبة ومعلوم أن السؤال لا يقتضي إيجاب الفعل على المسؤول ولا كراهة ضد ما سأله فعله وإنما يقتضي الإرادة فقط فوجب في الأمر مثل
ذلك إذ لو اقتضى الوجوب أو كراهة ضد المأمور لا نفصل من السؤال بشيء زائد على الرتبة
ومنها أن الأمر ضد النهي ولا معنى لكونه ضدا له إلا أن فائدته ضد فائدته وفائدة النهي كراهة الناهي المنهي عنه لا غير فكان فائدة الأمر إرادة المأمور به لا غير لأنها ضد الكراهة
ومنها أن الأمر يفيد أن الآمر مريد للفعل وما زاد على الإرادة لا دليل يدل على اقتضاء الأمر له فلم يجز أن يقتضيه فصح أنه يقتضي الإرادة فقط
ومنها أن صيغة الأمر يجوز استعمالها في التهديد والإباحة وإنما يتميز منهما بالإرادة فهي كافية في ثبوت حقيقة الأمر فلا افتقار بها إلى شيء من كراهة ضد المأمور به ومن غيرها ولو لم يتميز الأمر من غيره إلا بالكراهة لضد المأمور به لكان الأمر بالنوافل ليس بأمر على الحقيقة لأن الله تعالى ما كره أضدادها وقد أجمع المسلمون على أن الله سبحانه قد أمر بالنوافل وإنما مطيعون له بفعلها
ومنها أن قول القائل لغيره افعل هو طلب للفعل واستدعاء له فيجب أن يثبت معه من أحوال القائل ما يطابقه ليكون مستعملا في موضوعه والذي يطابق طلب الفعل بالقول إرادته وما عدا ذلك لا حاجة بالمأمور إليه من كراهة وغيرها
قالوا فثبت أن صيغة الأمر لا تفيد إلا الإرادة وليس يخلو إما أن تفيد إرادة مطلقة متعلقة بحدوث الفعل المأمور به أو إرادة على طريق الوجوب أو إرادة فعله لا محالة وليس يجوز أن تفيد إرادة فعله لا محالة لأن المعقول من قولنا إن الإنسان يريد أن يفعل غيره الفعل لا محالة هو أنه يريد فعله ويكره تركه وقد بينا أن الأمر لا يقتضي كراهة الترك ولو عقل من إرادة الفعل لا محالة غير ما ذكرناه لم يكن الأمر يقتضيها لما ذكرناه من الأدلة
وأما إرادة الفعل على طريق الوجوب فإن عني بها أنها إرادة الفعل لا محالة فقد أفسدناه وإن عني بها إرادة فعل المأمور به وإرادة أن ينوي المأمور الوجوب فذلك باطل لأنه لا دليل في الأمر على فعل هذه البتة
واستدلوا على أن الإرادة المطلقة لا تقتضي الوجوب بأن الإنسان قد يريد الواجب والندب والمباح والقبيح والله عز و جل إنما يريد من المكلفين في دار التكليف ما كان له صفة زائدة على حسنه لأن إرادة القبيح يستحيل عليه لأنها قبيحة وإرادة المباح من المكلفين لا فائدة فيها لأنه لا يترجح وجود المباح على عدمه في استحقاق ثواب ومدح فلم يكن في إرادته فائدة في دار التكليف وأما إرادة ما له صفة زائدة على حسنه فيحسن من الحكيم لأن ماله صفة زائده على حسنه إما أن يكون ندبا أو واجبا وإرادة كل واحد منهما يحسن من الحكيم فاذا حسن ذلك كان الواجب ينفصل من الندب باستحقاق الذم على الإخلال به وهذه زيادة لا يقتضيها حكم الأصل في كثير من الأفعال لم يجز إثباتها إلا لدليل زائد فمتى لم يحصل دليل زائد وجب نفيها كما أنه لما يثبت دليل يقتضي وجوب صلاة زائدة وجب نفيها
قالوا والرتبة أيضا لا تقتضي الوجوب لأن العالي الرتبة قد يأمر بالندب كما أنه قد يأمر بالواجب فلم تكن الرتبة مقتضية للوجوب والجواب أما قولهم أولا إنه ليس في صيغة الأمر ذكر للوجوب فانه يقال لهم وليس في صيغة الأمر ذكر للإرادة ولا لكون الفعل مندوبا وأيضا فانه لا يمتنع أن لا يكون ذكر الوجوب الذي هو قولك أوجبت في صريحة ويكون هو لفظ آخر من ألفاظ الوجوب وذلك أنه يقتضي إيجاب الفعل لا محالة على ما بيناه كما أن قول القائل لغيره افعل لا محالة وقوله ألزمتك الفعل يقتضي الوجوب وإن لم يكن ذكر الوجوب في صريحها وأما قولهم إنه لا فرق بين قول القائل لغيره افعل وبين قوله لغيره أريد منك أن تفعل فانه يقال لهم أتعنون أنه لا فرق بينهما في أن كل واحد منهما موضوع للإرادة كما وضع قولنا سواد للسواد أو تعنون أنه وضع لشيء آخر والإرادة تفهم تبعا له
فان قالوا بهذا الثاني وربما فسروا كلامهم به قيل لهم فقد أقررتم أن قولنا افعل موضوع لشيء غير الإرادة فبينوا انه غير الواجب حتى يتم دليلكم وإن أردتم الأول لم نسلمه لكم فان استدللتم عليه بما ذكرتموه قيل لكم لا نسلم أنه لا فرق بين قول القائل لغيره افعل وبين قوله أريد منك أن تفعل بل بينهما فرق وهو أن قوله افعل يفيد أن يفعل لا محالة ويفيد الإرادة من حيث كان المتكلم بهذا الكلام باعثا على الفعل ولا يجوز أن يبعث إلا على فعل ما له فيه غرض ولو عزلنا هذا عن أنفسنا لم نعلم أنه مريد للفعل وليس كذلك قوله أريد منك أن تفعل لأن ذلك صريح في الإخبار عن كونه مريدا وليس بصريح في استدعاء الفعل فضلا عن أن يكون مستدعيا لا محالة وأما قولهم إنه لافرق بين السؤال وبين الأمر إلا بالرتبة فالجواب عنه أنه لا فرق بين الأمر والسؤال في اقتضائهما للفعل لا محالة ألا ترى أن الواحد منا إذا قال اللهم اغفر لي أو قال للامير اخلع علي فإنه يجد من نفسه أن يطلب وقوع ذلك لا محالة وأن لا يقع الإخلال به وإن أورد ذلك على طريق التضرع وعلم أن إيصال الخلعة إليه تفضل لا يستحق بالاخلال به الذم فكأنه يقول أنا أعلم أن ذلك تفضل ولكني أطلب أن يفعل بي لا محالة ألا ترى أن السائل قد يصرح بذلك فيقول اخلع علي أيها الأمير ولا تخل بالتفضل علي بالخلعة
فان قيل فاذا كان قول السائل للمسؤول افعل هو طلب للفعل لا محالة وكان السائل بذلك طالبا للفعل لا محالة فقد أراد الفعل لا محالة وإلا لم يكن مستعملا للفظة فيما وضعت له وقولنا أراد الفعل لا محالة يفيد أنه أراده وكره ضده وتركه وفي ذلك كونه كارها للحسن لأنه قد يكون ضد ما سأله حسنا وكراهة الحسن قبيحة قيل قد بينا أن الإنسان إذا سأل غيره شيئا فقد طلب أن يفعله لا محالة ويجري مجرى أن يقول أعطني مالا ولا تخل بذلك وقد يصرح السائل بذلك ولا شبهة في أن ذلك طلب للفعل لا محالة والسائل بهذا الكلام طالب للفعل لا محالة أفتقولون إن من قال ذلك يكره ضد
ما سأل فان قالوا لا مع أنه طالب أن يفعل المسؤول الفعل لا محالة قلنا مثله في السؤال إذا تجرد عن نهي وإن قالوا هو كاره لضد ما سأله وكراهة الحسن قبيحة كانوا قد التزموا ما عابوه وإن قالوا لا يمتنع حسن كراهة الحسن قلنا مثله في السؤال ويقال لهم كراهة الحسن قبيحة إذا كانت كراهة له لأنه حسن فأما إذا كانت كراهة له لأن فيه مضرة أو فوت منفعة فلا ألا ترى أن الإنسان يقول خرج زيد من عندي آخر النهار وإني لكاره لذلك لما لي في كونه عندي من الأنس ولا يلومه أحد على ذلك ولو قال أردت أن يقتل زيد عمرا لأنني أحسده واستضر بجسدي إياه لامه العقلاء فليس يلزم حسن إرادة القبيح على حسن كراهة الحسن لا لحسنه وما نذكره في الكتاب من إطلاق قبح كراهة الحسن إنما جرينا فيه على طريقة أصحابنا
فان قالوا لو كان السائل قد طلب الفعل لا محالة لكان قد أوجب على المسؤول فعل ما ليس بلازم قيل الملزم غيره الفعل والموجب عليه هو الذي يلحقه الذم واللوم بالإخلال به إما بحق وإما بغير حق وذلك مرتفع عن السائل فلم يكن موجبا ولا ملزما للفعل
فان قالوا فإذا كان السؤال يقتضي الفعل لا محالة ولا يوجبه فما أنكرتم أن يكون الأمر يقتضي الفعل لا محالة ولا يوجبه قيل إنا نقول إن لفظة افعل تقتضي استدعاء الفعل لا محالة وقد يستدعي بها الإنسان القبيح والمباح لمنافعه وإنما نعلم أنها استدعاء وطلب لما ليس بقبيح ولا مباح إذا صدرت من حكيم ولا تجوز عليه المنافع والمضار أو ناقل عمن لا يجوز عليه المنافع والمضار وذلك يمنع أيضا أن يكون استدعاء أن يفعل المأمور الفعل لا محالة وليس هو بواجب فعله لأنه لا يحسن أن يقال للمكلف افعل هذا الفعل لا محالة وهو بصفة الندب إلا وبين له أنه بصفة الندب الذي يجوز له الإخلال به لأن الله إنما يأمرنا بمصالحنا ويستحيل عليه المنافع والمضار ولا
يجوز أن يقول الحكيم لغيره افعل هذا الفعل لا محالة وهو يعلم أنه ينتفع به ولا يستضر بتركه بل لا بد أن يبين له جواز تركه فاذا لم يبينه ثبت الوجوب لأن تقدير الأمر بالنوافل الأولى أن تفعل ولك أن لا تفعل وهذه زيادة فافتقر إثباتها إلى دليل فمتى فقد الدليل فلا بد من الوجوب
وأما الجواب عن قولهم إن النهي لا يقتضي إلا كراهة الناهي للمنهي عنه فهو أنا لا نسلم ذلك في النهي بل قول القائل لا تفعل هو طلب للإخلال بالفعل لا محالة كما أن قوله افعل هو طلب للفعل لا محالة وإنما تعقل الكراهة على طريق التبع من حيث لم يجز أن يمنع المتكلم إلا مما هو كاره له وأيضا إن قولنا لا تفعل كالنفي لقولنا افعل فان اقتضى النهي الكراهة فيجب أن يقتضي الأمر نفي الكراهة فقط
وأما الجواب عن قولهم إن لفظة افعل تدخل في أن يكون أمرا بالإرادة لا غير والإرادة لا تقتضي الوجوب فهو أن هذا إنما يدل على أن ما به يكون الأمر أمرا وهو الإرادة لا يفيد الوجوب ولا يدل على أن الصيغة ما وضعت للوجوب وأحد الأمرين مباين للآخر ألا ترى أنه لا يمتنع أن يقول أهل اللغة قد وضعنا قولنا افعل للوجوب وسمينا قولنا افعل أمرا إذا أراد المتكلم بها الفعل سواء استعملت في الوجوب أو في الندب ألا ترى أن المخالف يقول قد وضعت لفظة افعل للإرادة ووضعت بأنها صيغة افعل سواء استعملت في الإرادة أو في الكراهة
وأما الجواب عن قولهم إن لفظة افعل تفيد الإرادة وما زاد عليها لا دليل على إفادتها له فهو أنهم إن أرادوا أنها موضوعة للإرادة فغير مسلم وقد أفسدناه من قبل وإن أرادوا أنها موضوعة لغير الإرادة والإرادة مفهومة منها على طريق التبع قيل لهم فقد بطل قولكم لا دليل يدل على اقتضائها على ما زاد على الإرادة
وأما الجواب عن قولهم إنه ينبغي أن يثبت من أحوال الآمر ما يطابق
قوله افعل فهو أن ذلك صواب غير أن قوله افعل يقتضي ظاهره أن يفعل لا محالة والذي يطابق ذلك هو الإرادة والكراهة لضد الفعل فعليهم إفساد ذلك حتى يتم دليلهم
وربما استدلوا على أن الأمر ليس على الوجوب بأن السلطان قد يأمر بالحسن وبالقبيح ويوصفان بأنهما مأمور بهما على الحقيقة ويوصف السلطان بأنه أمر على الحقيقة فلو كان الأمر يفيد الوجوب لما وصف هذين بأنهما مأمور بهما والجواب أن هذا إنما يدل على أن لفظة افعل متى صدرت من مريد للفعل كانت أمرا على الحقيقة ولا تدل على أن صيغها التي هي قول القائل افعل ما وضعت للوجوب وقد بينا فرق ما بين الموضعين وربما قالوا لو اقتضت الوجوب لكانت إذا تناولت القبيح جعلته واجبا وهذا إنما يفسد بكونها جاعلة للفعل واجبا ولسنا نقول ذلك بل نقول إنها موضوعة لاقتضاء الفعل لا محالة والمتكلم بهما قد طلب الفعل لا محالة فاذا كان حكيما يستحيل عليه المنافع والمضار علمنا أن الفعل مما يجب أن يفعل لا محالة ولا يلزم إذا استعملت في غير الإيجاب أن لا تكون موضوعة له لأنها مستعملة في غير الإرادة ولا يمنع ذلك عندهم من وضعها لها وصيغة العموم قد تستعمل فيما دون الاستغراق ولا تدل على أنها ما وضعت للاستغراق
باب في صيغة الأمر الواردة بعد حظر
اعلم أنها إذا وردت بعد حظر عقلي أو شرعي أفادت ما تفيده لو لم يتقدمها حظر من وجوب أو ندب وقال جل الفقهاء إنها تفيد بعد الحظر الشرعي الإباحة والإطلاقودليلنا أن صيغة الأمر إنما وجب أن تحمل على الوجوب لأنها موضوعة له وقد صدرت من حكيم وتجردت عن دلالة تدل على أنها مستعملة في غيره
وهذه الأمور قائمة بعد الحظر فدلت على الوجوب
ويمكن المخالف أن يقول إنها بعد النهي موضوعة للإباحة في أصل اللغة أو في العرف وأن يقول إنها موضوعة للإيجاب في الأحوال كلها غير أن تقدم النهي من الآمر دلالة على أنه استعملها في الإباحة والأول باطل لأن المعقول من لفظة افعل البعث على الفعل واستدعاؤه دون التخيير بين الفعل وتركه والإباحة هي تخيير بين الفعل وتركه فلم تكن مستفادة من صيغة الأمر ولأن هذا القول لا يشهد له أهل اللغة فهو جار مجرى أن يقال إن الأمر يقتضي الوجوب في مكان دون مكان ولأنا لو عزلنا عن أوهامنا أن الشيء المأمور به مما تجب إباحته لولا النهي لما سبق إلى أفهامنا من الأمر الإباحة ولهذا إذا قال الأب لابنه اخرج من الحبس إلى المكتب لا يسبق إلى الأفهام إباحة الخروج
فان قالوا لو لم يفد الإباحة لم يكن لها لفظ بعد الحظر قيل بلى لها ألفاظ وهو قوله أبحت وأطلقت وافعل إن شئت وأنت مخير بين الفعل وتركه فأما إن قيل إن تقدم الحظر دلالة على أن المتكلم استعمل صيغة الأمر في الإباحة كما أن العجز دلالة على أن المتكلم لم يعن بالأمر العجز فالذي يبطله هو أن ذلك إنما يكون دلالة على ما ذكروه لو لم يجز انتقال المحظور من كونه محظور إلى كونه واجبا فأما وذلك جائز فلا دلالة فيه على العدول عن ظاهر الأمر ولهذا كان الأمر الوارد بعد حظر عقلي يفيد الوجوب
فان قيل الظاهر من الشيء المحظور بالنهي أن لا ينتقل إلى الوجوب قيل لا نسلم ذلك ولو كان كذلك لكان معنى قولكم أن الظاهر ما ذكرتم أنه الأكثر والأغلب وذلك يقتضي غالب الظن فان المحظور بالنهي لا ينتقل إلى الوجوب والأمارة الدالة على الظن لا تنتقل عن موجب الدلالة الدالة على العلم والأمر الصادر عن الله سبحانه دلالة على العلم وليس وجداننا أوامر واردة بعد الحظر وهي مستعملة في الإباحة مما يقتضي أن ذلك هو ظاهرها كما أن
وجداننا ألفاظ عموم لم يرد بها الإستغراق لا تدل على أنها ما وضعت لذلك وقد قال قاضي القضاة إن الأمة إنما حملت قول الله سبحانه فاذا حللتم فاصطادوا وقوله سبحانه فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض على الإباحة لأنها علمت من قصد النبي صلى الله عليه و سلم ضرورة أن هذه الأشياء مباحة لولا ما عرض فيها من إحرام أو تشاغل بالصلاة وما أشبه ذلك وقد يعلم الإنسان أن زيدا لا يوجب على عبده الخروج من الحبس بل يبيحه له إلا عندما يريد حبسه فيه فلهذا نعلم أنه إذا قال له اخرج من الحبس أنه قد أباحه الخروج وربما كان موجبا بذلك عليه الخروج وهو الأكثر في العبيد لما يعرض من كونهم في الحبس من مضرة المولى بانقطاعهم عن خدمته
باب في الأمر بالأشياء على طريق التخيير هل يفيد وجوب جميعها على البدل
أم يفيد وجوب واحد منها لا بعينهاعلم أنه ينبغي أن نبين معنى قولنا إن الأشياء واجبة على البدل ومعنى إيجاب الله سبحانه إياها على البدل ونبين الشرط في إيجابها على البدل ونبين جواز ورود التعبد بها على البدل ونبين الطريق إلى ثبوت التعبد بالأشياء على البدل وأن الله سبحانه قد تعبدنا بالأشياء على البدل ونبين كيفية التعبد بها
فأما معنى قولنا إن الأشياء واجبة على البدل فهو أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها ولا يلزمه الجمع بينها ويكون فعل كل واحد منها موكولا إلى اختياره لتساويها في وجه الوجوب ومعنى إيجاب الله سبحانه لها هو أنه كره ترك جميعها وأراد كل واحد منها ولم يكره ترك كل واحد منها إذا فعل المكلف الآخر وفوض إلى المكلف فعل أيها شاء وعرفه جميع ذلك وقد
يجوز أن يريد جميعها على البدل وعلى الجمع ويفارق ذلك الواجبات المرتبة نحو التيمم مع تعذر الوضوء لأن فعل التيمم والوضوء ليس بموكول إلى اختيار المكلف وقد دخل في ذلك تخيير اللابس للخفين بين أن يمسح عليهما أن يغسل رجليه وإن تعين عليه غسلهما عند ظهورهما لأن تبقية الخف ونزعه موكول إلى اختياره
فأما شروط إيجاب الأشياء على التخيير فضربان أحدهما أن يتمكن المكلف من الفعلين بأن يقدر عليهما ويتميزان له والآخر أن يتساوى الفعلان في الصفة التي تناولها التعبد نحو أن يكونا واجبين أو ندبين لأنه لو خير الله سبحانه بين قبيح ومباح لكان قد فسح في فعل القبيح تعالى الله عن ذلك ولو خير بين ندب ومباح لكان قد جعل للمكلف أن يفعله وأن لا يفعله من غير أن يترجح فعله على تركه وذلك يدخله في كونه مباحا ولو خير بين واجب وندب لكان قد فسح في ترك الواجب لأنه قد اباحه تركه إلى غيره
وقد قيل إن الله سبحانه لما خير بين تقديم الزكاة وتأخيرها لم يخير بين واجب ونفل وإنما خير الإنسان بين أن يجعل نفسه عند حؤول الحول على الصفة التي تلزم معها الزكاة بأن لا يقدم الزكاة وبين أن يخرج نفسه عن هذه الصفة بأن يقدمها وعندنا أنه إنما خير بين التقديم والتأخير لأن كل واحد منهما يسد مسد صاحبه في المصلحة ولا يجوز أن يخير الإنسان بين أن يفعل الفعل ولا يفعله إلا إذا كان مباحا لهذا قال شيوخنا إن الإنسان إنما خير بين الصوم في السفر وبين العزم عليه في الحضر وعند قوم أنه خير بين الصوم في السفر وبين الصوم في الحضر فلم يحصل التخيير بين الفعل وتركه
فأما الدلالة على جواز التعبد بالأشياء على التخيير فهي أنه لا يمتنع في العقل أن يصلح زيد عند كل واحد من فعلين كما لا يمتنع ان يصلح عند فعل واحد معين وكما جاز أن يكون الفعل صلاحا لشخص واحد جاز أن يكون الفعلان صلاحا في واجب واحد ألا ترى أن الإنسان قد يظن أن ولده لا يمضي إلى
المكتب إلا إذا أمر يده على رأسه وقد يظن أن يمضي عند ذلك وعندما يهب له درهما وإذا لم يمتنع ذلك في الأفعال لم يحسن أن لا يكلف ولا واحدا منها لأن فيه تفويت مصلحتنا ولا ان يوجب مجموعهما لأن المصلحة تحصل من دون مجموعهما فلا وجه لوجوبهما على الجمع ولا أن يوجب أحدهما بعينه لأنه يكون المكلف قد فصل بينهما في الوجوب مع اشتراكهما في وجه الوجوب
وأما الكلام في طريق ورود التعبد بالأشياء على البدل فضربان أحدهما عقلي والآخر سمعي أما العقلي فيجوز أن يعلم بالعقل تساوي شيئين أو أكثر في وجه الوجوب كرد الوديعة بكل واحدة من اليدين وأما الشرعي فضربان أحدهما مشروط بطريقة عقلية والآخر غير مشروط بطريقة عقلية أما ألأول فنحو أن يأمرنا الله سبحانه بأشياء في وقت واحد ويستحيل الجمع بينهما فنعلم أنها على التخيير وأما الثاني فضربان أحدهما أن يرد السمع بتساوي أشياء في وجه الوجوب والآخر أن يرد بايجاب أشياء على طريق التخيير وذلك نحو الكفارات الثلاث
وقد ذهب الفقهاء إلى أن الواجب منها واحد لا بعينه وقال بعضهم إن الواجب منها واحدة وأنها تتعين بالفعل وذهب شيخانا أبو علي وأبو هاشم إلى إن الكل واجبة على التخيير ومعنى ذلك أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها ولا يجب الجمع بين اثنين منهما لتساويهما في وجه الوجوب ومعنى إيجاب الله إياها هو أنه أراد كل واحدة منها وكره ترك أجمعها ولم يكره ترك واحدة منها إلى الأخرى وعرفنا ذلك فان كان الفقهاء هذا أرادوا وهو الأشبه بكلامهم فالمسألة وفاق وكل سؤال يتوجه علينا فهو يتوجه عليهم يلزمنا وإياهم الانفصال عنه وإن قالوا بل الواجب واحد معين عند الله غير معين عندنا إلا أن الله سبحانه قد علم أن المكلف لا يختار إلا ما هو الواجب عليه فالخلاف بيننا وبينهم في المعنى
والدليل على ما قلناه قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين
من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة الآية وقوله فكفارته إطعام إيجاب للإطعام وقوله أو كسوتهم عطف على الاطعام تقديره أو كفارته كسوتهم فشرك بينهما في الإيجاب لا على الجمع فكانا واجبين على التخيير فصح أن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في الوجوب فان قيل قوله فكفارته إطعام يجوز أن يكون إخبارا عما يحصل من الكفارة فكأنه قال فما يوجد من الكفارة هو إطعام أو كسوة من حانث آخر أو عتق قيل هذا الكلام من الله هو إيجاب لرجوع الأمة إلى الآية في إيجاب الكفارة وايضا لو كان كما ذكرتم لما كان الخطاب راجعا إلى كل من حلف وإنما كان يرجع أوله إلى بعض من حلف وثانيه إلى بعض آخر وثالثه إلى بعض ثالث لأنه ليس كل من حلف فقد كفر ولا كل من كفر فقد كفر بالإطعام فان قيل إنما قال عز و جل فكفارته إطعام ثم قال أو كسوتهم أو تحرير رقبة لأن بعض المكلفين يلزمه الإطعام وبعضهم يلزمه الكسوة وبعضهم يلزمه العتق فكأنه قال فكفارته إطعام عشرة مساكين لبعضهم أو الكسوة لبعض آخر قيل إن قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم خطاب للكافة والمراد به كل واحد منهم لاتفاق المسلمين على أن كل حانث قد قيل له كفر بالإطعام أو الكسوة أو بالعتق ولم يقل أحد إن الله سبحانه قال لواحد كفر بالإطعام وقال لآخر كفر بالكسوة يبين ذلك أن حمل الآية على ذلك يحوج إلى إضمار حتى يكون تقديره فكفارته إطعام عشرة مساكين لبعضكم أو كسوتهم لبعضكم وليس يجوز إضمار لا دليل عليه وأيضا فلو كان قوله فكفارته خطابا للكافة لا لكل واحد منهم لقال فكفارته إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة لأن الثلاثة واجبة على الجمع عليهم ألا ترى أنه يجب على
بعضهم الكسوة فقط في حال ما يجب الإطعام فقط على آخرين في حال ما يجب العتق فقط على أخرين
دليل آخر لو كانت الواحدة من الكفارات واجبة بعينها على المكلف لعينها الله عز و جل له وإلا كان قد كلفه ما لا طريق له إليه وذلك لا يجوز وليس في شيء من الأدلة تعيين لكفارة من الكفارات
دليل آخر قد خير الله سبحانه والمسلمون كل مكلف بين الكفارات الثلاث فلو وجب واحدة منها على المكلف لا غير لكان الله سبحانه قد خيره بين الواجب وبين ما ليس بواجب وفي ذلك إباحة الإخلال بالواجب إن قيل إنما خير الله بين الكفارات وإن كان الواجب منها واحدا لأنه قد علم أن المكلف لا يختار إلا الواجب قيل له ليس يخلو اختياره للواحدة منها إما أن يكون له تأثير في كونها مصلحة واقعة على وجه الوجوب أو ليس له تأثير في ذلك فان لم يكن له تأثير في ذلك أدى إلى أن يتفق وقوع المكلفين مع كثرتهم وطول أزمانهم على المصلحة دون المفسدة وذلك في التعذر كتعذر اتفاق الفعل المحكم ممن ليس بعالم به وفي ذلك جواز اتفاق تصديق أنبياء من جملة كذابين ممن لا يعلم الفرق بينهم وأيضا فلو صح وقوع الواجب اتفاقا لم يخرج الباري سبحانه من كونه مخيرا لنا بين الواجب وبين ما ليس بواجب ومبيحا لنا الإخلال بالواجب وإن علم أنا لا نخل به وأيضا فالأمة مجمعة على أن من كفر بواحدة من الكفارات لو كفر بغيرها أجزأه وكان مكفرا بما تعبد به فلو لم يكن ما كفر به واجبا لم يكن مجزئا فان قالوا لاختيار المكلف تأثير في كون الفعل المختار مصلحة قيل لهم ليس يخلو إما أن تكون مصادفة الاختيار لأي فعل أشير إليه تجعله مصلحة حتى يكون الاختيار وحده هو المؤثر في كون الفعل المختار صلاحا أو تكون مصادفته لواحدة من الكفارات الثلاث هو المصلحة فان قالوا بالأول لزمهم أن يكون للمكلف أن يختار أن يكفر بغير الإطعام والكسوة والعتق وإن قالوا بالثاني قيل لهم اشترك الكفارات الثلاث في الوجه الذي به فارقت ما ليس منها وهو الذي
صار له الفعل مصلحة إذا قارنه الاختيارأو لا تشترك في ذلك بل الواحد منها هو مختص بهذا الوجه فقط فان قالوا بالثاني قيل لهم فاذا الذي يكون مصلحة إذا اخترناه هو واحد منها فقط وهذا يمنع منه تخيير الله سبحانه المكلف بين أن يفعله وبين أن يتركه ويفعل غيره ويجب أن لو فعلنا غيره أن لا يجزئنا والأمة مجمعة على أنه يجزئنا فان قالوا لا يمتنع أن يكون ما عدا تلك الكفارة مباحا ويسقط به الفرض كا تقولون إن القبيح يسقط به الفرض قيل إن الأمة كما اجتمعت على أن المكفر بواحدة من الكفارات لو كفر بغيرها اجزأه فقد أجمعت أيضا على أنه لو كفر بغيرها لكان قد فعل الواجب وما تعبد به وأيضا فاني إنما أجوز في القبيح أن يسقط به الفرض إذا كان سادا لمسد الواجب في وجه المصلحة وإنما قبح ولم يدخل تحت التكليف لأن فيه وجها من وجوه القبح أو لأنه إذا فعله المكلف صار لو فعل ذلك الواجب لم يكن على صفة المصلجة فيسقط وجوبه لهذا وأما المباح فلو سقط به الواجب لكان إما أن يسقط به لأنه إما قد ساواه في وجه الوجوب وفي ذلك كونه واجبا لأنه ليس فيه وجه قبح يمنع من وجوبه وإما أن يسقط الواجب لأنه يصير معه غير مصلحة فذلك يجعله مفسدة لأن عنده يبطل لطف المكلف ويصير فاعلا لقبيح ولولاه لكان له لطف يصرفه عن ذلك القبيح وإن قالوا الكفارات الثلاث تشترك في الوجه الذي تتميز به مما ليس بكفارة وهو الذي لمكانه صار كل واحد منها إذا ضامه الاختيار مصلحة قيل لهم فقد وجب أن تكون كل واحدة منها لو فعلت سدت مسد الأخرى في المصلحة وهذا هو قولنا والذي يبقى بيننا وبينكم ما قلتموه من أن يكون للآختيار تأثير في كون الفعل مصلحة مع ما عليه الفعل من الوجه وهذا لا معنى له لأن المكفر عالم بما يفعله ومن هذه سبيله منا لا بد من أن يقصد ويريد ما يفعله وما لا بد منه في الفعل لا معنى لاشتراطه في المصلحة لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يجعل اختيار كل فعل واجب شرطا في كونه واجبا
فأما من ذهب إلى أن الواجب من الكفارات واحدة وأنها تتعين بالفعل
فيقال لهم ما معنى قولكم إنها تتعين بالفعل فان قالوا إذا فعلت لزم فعلها مرة ثانية قيل لهم إن أردتم تكرير مثلها فذلك غير واجب باتفاق وإن أردتم فعل نفس ما فعله فذلك غير ممكن ولو أمكن لم يجب فان قالوا نريد بذلك أنه إذا فعلها علمنا أنها هي التي كانت واجبة عليه دون غيرها قيل فكان يجب أن يدلنا الله عز و جل على وجوبها بعينها ولا يخيرنا بينها وبين غيرها ولا تجمع الأمة على أنه لو كرر بغيرها أجزأه فإن قالوا معنى ذلك أنه إذا فعلها أجزأه في إسقاط الفرض قيل وكذلك ما لم يفعله لو فعله أجزأه
والذي والذي ذكروه نسلمه وليس هو موضع الخلاف فهذه القسمة تبطل قول المخالف ويزول معها اعتراضات وقد أفسد أصحابنا قول المخالف بهذه على الوجوه غير هذه القسمة فقالوا لو كان الواجب واحدة من الكفارات لعينها الله سبحانه بالوجوب ولما وكل فعلها إلى اختيارنا لأن الإنسان قد يختار المصلحة والمفسدة كما لم يجز أن يكل إلينا اختيار نبي من غير أن يدلنا عليه بمعجزة ولقائل أن يقول إنما يتم هذا الكلام لو كانت الكفارة مصلحة من دون الاختيار فيقال يجوز أن يختار المكلف المصلحة ويجوز أن يختار ما ليس بمصلحة كما أن النبي يكون نبيا من دون اختيارنا اعتقاد نبوته فأما إذا قلنا إن تأخيرنا مكمل كون ما يفعله مصلحة فإنا نعلم أن ما نختاره هو المصلحة لأجل اختيارنا لا لأنه صادف اختيارنا ما هو مصلحة فيقال فاذا جاز أن يصادف اختياركم المصلحة جاز أيضا أن يصادف أيضا ما ليس بمصلحة
وقالوا أيضا لو كانت الواحدة من الثلاث واجبة فقط وهو الذي يختاره المكلف لكان لو كفر بغيرها لم تجزئه والإجماع واقع على انه يجزئه ولقائل أن يقول إذا جعلت المصلحة أن أفعل الكفارة وأنا مختارها وجب لو لم يفعل المكلف ما فعله وفعل غيره أن تكون مصلحة أيضا لنه قد فعله وهو مختار له
وقالوا أيضا كان يجب لو اخل بالثلاث أجمع أن لا يستحق ذما لأنه إنما يجب عليه واحدة منها إذا اختاره فاذا لم يختره لم يحصل الشرط ولقائل أن يقول المصلحة إنما تحصل باحدى الكفارات مع الاختيار فان لم توجد فاتت المصلحة فجرى مجرى لطف يحصل بمجموع فعلين وجرى مجرى قولكم إن بيع الأرز متفاضلا إنما يكون مفسدة إذا غلب على ظن المجتهد شبه بالبر ولا يجوز مع ذلك إقدام المجتهد على بيعه متفاضلا إذا لم يجتهد في تحريمه بل يلزمه أن يجتهد حتى إذا أداه اجتهاده إلى تحريمه اجتنبه
وقالوا أيضا لو كانت الواحدة من الكفارات واجبة فقط لكان قد خير الله سبحانه بين الواجب وبين ما ليس بواجب ولقائل أن يقول إنما تصير مصلحة باختيار المكلف وأيها فعل وهو مختار له فقد فعل المصلحة فلم يخير بين المصلحة وبين ما ليس بمصلحة
واحتج المخالف بأشياء
منها أنه لو كان كل واحدة من الكفارات واجبة لوجب الجمع بينها إذ كل واحدة منها على وجه الوجوب وإذا وجدت واحدة منها لم تخرج الأخرى من أن تكون لو فعلت لوقعت على وجه الوجوب والجواب أن كل واحدة منها تختص بوجه وجوب يقوم فيه مقام الأخرى فتسقط المصلحة الاولى فلم يجز أن تجب الأخرى مع أن الحانث قد استوفى المصلحة بالاولى يبين ذلك أن الإطعام إذا كان مصلحة في رد وديعة وكانت الكسوة تسد مسده في ذلك فانه إذا أطعم الحانث فرد الوديعة قام الإطعام مقام الكسوة ولم يبق شيء تكون الكسوة مصلحة فيه فلم يجز أن يجب
ومنها قولهم كان يجب لو كفر الحانث بها معا أن تكون كلها واجبة إذ ليس بعضها بذلك أولى من بعض وأجاب قاضي القضاة بأنا لا نقول بهد إيجادها بأنها واجبة عليه لأن ذلك يفيد لزوم فعلها وذلك مستحيل بعد
إيجادها وإنما يقال في الموجود إنه واجب ولا يقال إنه واجب على أحد ولا يقال في الكفارات الموجودة معا إنها واجبة لا على الجمع ولا على البدل والتخيير لأن التخيير والبدل إنما يصحان على المعدوم دون الموجود قال فلو قلنا إنها واجبة لكانت واجبة على الجمع وذلك باطل ولقائل أن يقول إذا لم تكن بعد إيجادها موصوفة بالوجوب لا على التخيير ولا على الجمع ولا كل واحد منها على وجه وجوب لأنكم لا تصفون كل واحدة بأنها واجبة فانه يلزمكم أن تقولوا إن واحد منها واجب لا يتعين عندنا وإذا قلتم ذلك لزمكم أن يكون ذلك الواحد هو الواجب قبل وجوده لأنه إنما كان كل واحد منها واجبا قبل وجوده على البدل لأن كل واحد منها لو وجد لكان على وجه الوجوب فان كانت إذا وجدت فواحد منها فقط على وجه الوجوب فذاك إذا هو الواجب على المكلف قبل وجوده ما لم يوجد الآخر فأما إذا وجد الآخر فلا قيل له فاذا وجدت معا لم يكن بعضها بأن يخرج من أن يكون على وجه الوجوب لأجل وجود الآخر بأولى من العكس فيلزم أن يخرج كلها عن صفة الوجوب ونحن نجيب عن الشبهة فنقول للسائل إن أردت بقولك هل هي واجبة كلها انه يلزم فعلها مع أنها مفعولة فذلك مستحيل ولا يبقى بعد ذلك إلا أن تقول هل هي على صفات كان يلزم لمكانها إيجادها إما على الجمع وإما على البدل فجوابنا أما أن تكون واجبة على الجمع فلا وأما على البدل فنعم هي بعد وجودها واجبة على معنى أن كل واحد منها على صفة متساوية للصفة الأخرى ولمكان تلك الصفة يلزم إيجادها على التخيير وهو قولنا
ومنها ومنها قولهم لو كانت واجبة على البدل لم يخل إذا أطعم المكفر في حال ما كسا إما أن يسقط الغرض بكل واحد منهما وإما أن يسقط لمجموعهما أو بواحد منهما فلو سقط لمجموعهما لكانا واجبين على الجمع ولو سقط بكل واحد منهما لكان قد حصل حكم واحد عن مؤثرين وإن سقط بواحد منهما فذلك هو الفرض دون غيره والجواب أن الفرض يسقط بكل واحد منهما
لأن كل واحد منهما ساد مسد الآخر في وجه الوجوب فليس بأن يسقط بأحدهما أولى من أن يسقط بالآخر وذلك غير ممتنع ألا ترى أن المكلف لو قتل أحدا في حال ما ارتد لا يستحق قتله وهو حكم واحد بكل واحد من الردة والقتل ولو انكشفت عورة المصلي في حال ما وطيء على نجاسة وفي حال ما أحدث يخرج من الصلاة بكل واحد منها لأنه ليس بعضها بأن يؤثر في ذلك أولى من بعض وعلى أن هذه الشبهة التي قبلها تلزم المخالف إذا قال إن الواجب هو ما يختاره المكلف لأنه إذا كفر بالكسوة والعتق والإطعام معا فقد اختار كل واحد منها فوجب أن يكون كل واحد منها هو الواجب وبكل واحد منها يسقط الفرض وكذلك من قال يتعين الواجب بالفعل
ومنها ومنها قولهم لو قال الحانث للفقير ملكتك هذه الكسوة وهذا الطعام وقال مثل ذلك لباقي الفقراء يكون ذلك واجبا أو ندبا فان قلتم واجب لزمكم أن يكون الجمع بين الإطعام والكسوة واجبا وإن قلتم ندب لزمكم أن يكون هذا المكفر ما فعل الواجب وإن قلتم هو واجب وندب لم يكن بعضه بالوجوب أولى من بعض وكنتم قد صرتم إلى قول مخالفكم من أن الواجب أحدهما والجواب أنا نقول إنه واجب على معنى أنه يتضمن إفعالا لو انفرد كل واحد منها لأسقط الفرض ونقول إنه ندب على معنى أنه لا يلزمه أن يجمع بينهما ولا تناقض بين ذلك على هذا التفسير
ومنها قولهم لو كانت واجبة كلها لوجب إذا أطعم وكسا معا أن ينوي بكل واحد منها الوجوب لأنه ليس بأن يكون أحدهما هو الواجب أولى من الآخر والجواب يقال لهم إن أردتم بذلك أنه ينوي أنه يفعل ما يقوم مقام غيره في وجه المصلحة وإسقاط الفرض فنعم وهو مطابق لما فسرناه وإن أردتم به أنه ينوي بكل واحدة منهما أنه يلزمه فعله وإن فعل الآخر فلا ثم إن الشبهة لازمة لهم إذا قالوا إن بالاختيار أو بالفعل يتميز الوجوب لأن الاختيار قد حصل في كل واحد منهما
ومنها قولهم كان يجب لو أخل بكل واحدة من الكفارات أن يستحق الذم على الإخلال بكل واحدة منها لأن كلها واجبة فليس بأن يذم على ترك البعض أولى من البعض والجواب أنا لم نقل إنه يلزمه الجمع بينهما حتى يعاقب على كل واحدة منها ونقول يستحق قدرا من العقاب على الإخلال بالكل كما يذم على الإخلال بالكل ولا بقدر العقاب ويسقط كل شبهة وقد أجاب شيوخنا عنه بأنه يستحق الذم والعقاب على أدونها عقابا لأنه لو فعله ما استحق شيئا من العقاب فان قيل لو فعل أعظمها عقابا لما استحق الذم فيجب إذا أخل بالكل أن يستحق ذلك العقاب والجواب أنه إذا كان لو فعل أقلها عقابا سقط عنه العقاب فيجب إذا أخل بأجمعها ثم عوقب في كل وقت عقاب أقلها عقابا ان يجري بعد استيفاء هذا العقاب مجرى من فعل الكفارة التي هذا العقاب يستحق على تركها ولو فعلها لم يستحق عقابا فكذلك إذا استوفى عقابها والأولى أن يقال يستحق عقاب أدونها عقابا لما ذكرناه الآن لكنه يستحق ذلك على الإخلال بأجمعها لا بواحدة منها لأنها إذا كانت واجبة على البدل لم يجز أن يعاقب على الإخلال بواحد منها لأن في ذلك كونها هي الواجبة وإنما يعاقب كما يذم ومعلوم أنا لا نذمه لم أخل بواحدة وإنما نذمه لم أخل بالكفارات الثلاث فكذلك يعاقب ألا ترى أنا نلومه ونعنفه فنقول لم أخللت بجميعها ولا نقول لم أخللت بواحدة منها فان قالوا فاذا كان يستحق العقاب على الإخلال بأجمعها فكيف يتصور أن بعضها أقل عقابا وبعضها أزيد قيل بأن يكون بعضها أشق من بعض نحو العتق ويتصور أن لو وجب وحده لكان عقاب الإخلال به أقل من عقاب ترك الكسوة لو وجبت وحدها
ومنها قولهم لو كانت كلها واجبة لا يستحق فاعلها معا على كل واحد منها ثواب الواجب وأجاب أصحابنا عن ذلك بأنه إنما يستحق عليه ذلك الثواب ولقائل أن يقول ولو أفرد فعل أدونها ثوابا لكان واجبا ولا يستحق عليه ثوابه فيلزمكم على تعليلكم أن يستحق على ذلك ثواب الواجب ويستحق
ثواب الأعظم لا على أنه ثواب الواجب ثم يقال لهم أبزيادة الثواب صار واجبا أم لا فان قالوا نعم قيل فيجب أن يكون هذا الواجب قبل ايجاده وإن قالوا لا قيل لهم فما به صارت واجبة قد اشتركت فيه فلم صار الثواب الأزيد هو ثواب الواجب دون غيره ثم يقال لهم إنكم بقولكم أزيدها ثوابا هو الذي يستحق عليه ثواب الواجب دون غيره تسليم منكم أن ذلك هو الواجب دون غيره لأن ما لم يوجد إنما يوصف بالوجوب وحده لأنه إذا وجد اختص بوجه الوجوب دون غيره وهذا قد قلتموه في هذه الكفارة ونحن نجيب عن الشبهة فنقول للمستدلين قولكم على أنها تستحق ثوب الواجب تسليم منكم أن فيها واحد واجب يستحق عليه الثواب وأنكم تطلبون أيها هو ونحن قد بينا أن كل واحد منها واجب إذا وجدت معا على التفسير الذي ذكرناه فكل واحد منها يستحق عليه ثواب الواجب على معنى أنه يستحق عليه ثواب ما هو على صفة لو فعل وحده لأسقط الفرض ونقول إن كل واحد منها لا يستحق عليه ثواب الواجب إذا أريد بالواجب لزومه بعينه لأنه ليس فيها ما يلزم بعينه
واستدلوا على جواز ورود التعبد بواحد من الأشياء لا بعينه ويجعل ذلك موكولا إلى اختيارنا بأنه لا يمتنع أن يقول الله سبحانه أوجبت عليكم واحدة من الكفارات لا بعينها فافعلوا أيها شئتم ولو قال ذلك لوجبت واحدة منها لا بعينها والجواب أنه إن عني بقوله أوجبت عليكم واحدة منها لا بعينها أنه لا يلزمنا ضم واحدة إلى واحدة وأنه يلزمنا أيها شئنا لأن كل واحدة تقوم مقام الأخرى فصحيح وهو مذهبنا وإن عني أن الواجب والمصلحة واحد لم يعينه لنا وهو في نفسه متعين عند الله فذلك لا يجوز أن يقوله وهو موضع الخلاف
واستدلوا على أن التعبد بذلك قد ورد بأشياء
منها أن الحانث لا يلزمه عتق كل رقاب الدنيا وإنما يلزمه عتق واحدة
منها لا بعينها وذلك موكول إلى اختياره وكذلك العمي إذا أفتاه فقيهان بفتويين مختلفين أنه يلزمه أحدهما لا بعينه وكذلك إذا اعتدلت عند المجتهد أمارتان أنه يلزمه المصير إلى أحداهما لا بعينها وقد أجاب قاضي القضاة بأنه يلزمه عتق كل رقبة تمكن من عتقها على البدل وهذا هو مذهبنا وليس ذلك بمستحيل على التفسير الذي ذكرناه وكذلك يلزم العامي الأخذ بكل واحد من الفتويين على البدل وكذلك المجتهد إذا اعتدلت عنده الأمارتان
ومنها أن الإنسان لو عقد على قفيز من صبرة لكان المعقود عليه قفيزا منها لا بعينه وإنما يتعين باختيار والجواب أنه إذا عقد على قفيز من صبره فليس العقد بأن يتناول قفيزا منها أولى من قفيز لعقد الإختصاص فوجب أن يكون كل قفيز منها قد يتناوله العقد على سبيل البدل على معنى أن كل واحد منها لا اختصاص للعقد به دون صاحبه وللمشتري أن يختاره وإذا اختاره تعين ملكه فيه فتعين الملك في القفيز كسقوط الفرض بالكفارة وكذلك إذا طلق زوجة من زوجاته لا بعينها أو أعتق عبدا من عبيده لا بعينه أن كل واحد منهم معتق على البدل وكل واحدة منهن طالق على البدل على معنى أنه لا اختصاص للطلاق والعتق بواحد دون صاحبه وأنه أي نسائه اختار مفارقتها حلت له الأخرى وتعينت الفرقة عليها وأي عبيده اختار عتقه تعينت فيه الحرية وكان له استخدام الباقين وقد أجاب الشيخ أبو عبد الله وقاضي القضاة عن الشبهة فقالا إنه لما جاز أن يقف العقد على القفيز على الاختيار جاز أن يقف فرع من فروعه على الاختيار وظاهر ذلك يقتضي تسليم ما قاله المخالف من أن المبيع من الصبرة والمعقود منها قفيز يعلم الله عينه ولا نعلمه نحن وما عداه غير معقود عليه وكذلك المطلقة من النساء واحدة يعلم الله عينها ولو كان كذلك لوجب أن يعين الله سبحانه لنا المطلقة والقفيز المبيع وإلا كان قد خيرنا بين أن نقبض ما نملكه وما لا نملكه وبين المقام على المطلقة والتي ليست بمطلقة وبين ملك الحر والعبد فهذا هو الكلام في إيجاب الأشياء على جهة التخيير
فأما كيفية إرادة الله الأشياء التي أوجبها فنحن آخذون فيها فنقول إن الأشياء التي أوجبها الله سبحانه لا على الجمع ضربان أحدهما أوجبها على الترتيب والآخر أوجبها على البدل
أما الأول فهي التي تعبد ببعضها عند تعذر البعض كالتيمم عند عدم الماء وأكل الميتة عند تعذر الطعام والخوف على النفس أو عند وجود المشقة نحو التيمم عند وجود ماء بأكثر من ثمن مثله وما تعبد الله سبحانه به على الترتيب منه ما قد أراد جميعه وإن لم يجب جميعه نحو الصيام والعتق في كفارة اليمين وإن كان إذا فعل الصيام لا تكون كفارة منه ومنه ما لم يرد الجمع نحو أكل الميتة وأكل المباح من الطعام والأشياء المرتبة قد يكون منها ما يوصف بأنه رخصة وهو أن يكون أسهل والأصل غيره ولذلك المسح على الخفين رخصة وأكل الميتة رخصة
وأما الأشياء المتعبد بها على البدل فضربان أحدهما أرادها الله بأجمعها وإن لم يجب الجمع والآخر لم يرد الجمع فالأول نحو الكفارات الثلاث وأما الذي لم يرده أجمع فضربان أحدهما كره الجمع بينه نحو تزويج المرأتين كفوين والآخر لم يرد الجمع ولا كرهه نحو ستر العورة وكل ما يستحب ستره في الصلاة بثوب بعد ثوب لأن الثوب الثاني مباح ما أراده الله ولا كرهه وقد أراد الستر بكل واحد منها على البدل
باب في الأمر هل يدل على إجزاء المأمور به أم لا
ذهب الفقهاء بأسرهم إلى أنه يدل على ذلك وقال قاضي القضاة إنه لا يدل عليه وينبغي أن نذكر معنى وصفنا للعبادة بأنها مجزئة وغير مجزئة ثم نبني الكلام عليه فنقول إن وصف العبادة بأنها مجزئة معناه أنها تكفي وتجزيء في إسقاط التعبد بها وإنما يكون كذلك إذا استوفينا شروطها التي تعبدنا أن نفعلها عليها وذلك أنه لا فرق بين قولنا هذا الشيء يجزئني وبين قولنا إنه يكفيني والمعقول من قولنا إنه يكفيني أنه يكفي في غرض من الأغراض وكذلك المعقول من قولنا في العبادة إنها تجزيء هو أنها تكفي وتجزيء في إسقاط التعبد وإذا قلنا إن العبادة لا تجزيء فالمعقول منه أنها لا تجزىء في إسقاط التعبد بها وإنما لا تجزيء في ذلك لأنها لم تستوف شرايطها التي أخذ علينا إيقاعها عليها وتبع ذلك أن يجب قضاؤها بذلك التعبد إن لم تكن موقتة أو كان وقتها باقيا وأن يجوز أن يجب قضاؤها إن كان قد خرج وقتها وقد دخل تحت هذا الكلام العبادات الواجبة وغير الواجبة وليس معنى قولنا إن العبادة تجزىء أنها حسنة لأن المباح حسن ولا يوصف بأنه يجزىء وإنما يوصف المباح بأنه جائز على معنى أنه حسن غير قبيح وذكر قاضي القضاة أن معنى وصف العبادة بأنها مجزئة هو أنه لا يجب قضاؤها ومعنى وصفها بأنها لا تجزيء هو أنه يلزم قضاؤها وهذا غير مستمر لأن الله سبحانه لو أمرنا بالصلاة على طهارة فصلى الإنسان على غير طهارة ومات عقيب الصلاة أو بقي حتى خرج وقت الصلاة ولم يرد التعبد بالقضاء لوجب أن تكون الصلاة مجزئة إذ كان القضاء لم يجب وهو معنى كونها مجزئة عنده فإن قال العبادة التي هي غير المجزئة هي التي يجوز أن يجب قضاؤها أو كان يجوز أن يجب قضاؤها وما فرضتموه كان يجوز أن يجب عليه القضاء قيل فقد صارت العبادة المجزئة هي التي تكون على صفة لأجلها لا يجوز أن يجب قضاؤها والتي لا تجزيء تكون على صفة يجوز معها أن يجب قضاؤها فما تلك الصفة إذ هي معنى الإجزاء فلا بد عند ذلك من الرجوع إلى ما قلناه فيظهر أن المأمور به إذا فعل على حد ما أمر به لم يجز أن يجب قضاؤه
فاذا ثبت ذلك فلنتكلم في المسألة على كلا القولين فنقول إن كان معنى وصف العبادة بأنها مجزئة أنه قد سقط بها التعبد فمعلوم أن الأمر يدل على أن ما تناوله إذا فعل على حد ما تناوله مع تكامل الشرائط فهو يجزيء لأن
المكلف بهذا الفعل ممتثل للامر فلو قلنا إن التعبد بذلك الفعل باق عليه انتقض القول بأنه ممتثل للأمر لأن الأمر تعبد ولهذا نقول إن المضي في الحجة الفاسدة يجزيء في إسقاط التعبد بالمضي فيها وإنما لا يجزيء فيها إسقاط التعبد بحجة صحيحة لأن ذلك التعبد ما امتثل وكذلك الصلاة في آخر الوقت على ظن الطهارة تجزيء في إسقاط التعبد المتوجه إلى الظان في ذلك الوقت وإذا ذكر من بعد أنه كان محدثا توجه إليه أمر آخر لأنه إنما كلف الصلاة على طهارة إذا ذكر أمه كان محدثا حين صلى فأما كون العباد جائزة على معنى أنها حسنة فلا شبهة في أن الأمر يدل عليه لأن الأمر يدل على الوجوب أو على الندب والحسن داخل تحت كل واحد منهما
فأما القول بأن الأمر يدل على إجزاء المأمور به على معنى أنه يمنع من لزم القضاء فصحيح أيضا لأن قضاء العبادة الموقتة هو فعل واقع بعد خروج وقتها بدلا من فعلها في وقتها على الوجه المأمور به وذلك يكون إما لأن العبادة ما فعلت أصلا أو فعلت على وجه الفساد وذلك غير حاصل إذا فعلها الإنسان على وجه الصحة فلم يتصور القضاء اللهم إلا أن يقال يجب عليه بعد خروج الوقت فعل مثل ما فعله في الوقت ولا يكون قضاء لما فعله فذلك غير منكر والأمر لا يدل على نفي وجوب ذلك ألا ترى أن الأمر بصلاة الظهر لا يمنع من وجوب مثلها في العصر غير أنه لا يكون قضاء لها فان قيل أليس الماضي في الحجة الفاسدة قد امتثل الأمر في المضي فيها ويلزمه القضاء وكذلك المصلي في آخر الوقت على ظن الطهارة قيل الحجة الصحيحة لا تكون قضاء لمقتضى الأمر بالمضي في الحجة الفاسدة وإنما هي مفعولة لأجل أن الأمر بالحج الصحيح باق والصلاة المفعولة بعد خروج الوقت إذا ذكر المكلف أنه كان صلى على غير طهارة ليس بقضاء لمقتضى الأمر بالصلاة مع ظن الطهارة وإنما هو قضاء لمقتضى الأمر بصلاة على طهارة
باب في الأمر بالشيء هل يدل على وجوب ما لا يتم الشيء إلا به أم لا
اعلم أنه ينبغي أن نذكر الأشياء التي لا تتم العبادة إلا معها ثم نذكر متى يدل الأمر على وجوب ما لا يتم المأمور به إلا معه ومتى لا يدل ويدل على كلا القسمينونبدأ بالأول فنقول إن ما لا تتم العبادة إلا به ضربان أحدهما هو كالوصلة والطريق المتقدم على العبادة والآخر ليس كالوصلة المتقدمة فالأول ضربان أحدهما يجب بحصوله حصول ما هو طريق إليه والآخر لا يجب ذلك فيه فالأول ضربان أحدهما يجب بحصوله حصول ما هو طريق إليه والآخر لا يجب ذلك فيه فالأول نحو أن يأمرنا الله سبحانه بإيلام زيد فإن وصلتنا إلى ذلك هو ضربة ومحال وجود الضرب الشديد في بدنه مع احتماله الألم ولا يألم والثاني ضربان أحدهما تحتاج إليه العبادة بالشرع والآخر تحتاج إليه في نفسها لا بالشرع أما الأول فكحاجة الصلاة إلى تقديم الطهارة وأما الثاني فكالتمكن على اختلاف أقسامه كالقدرة والآلات وقطع المسافة إلى أقرب الأماكن من عرفة والتمكن منه ما يصح من المكلف تحصيله كقطع المسافة وإحضار بعض الآلات ومنه ما لا يصح من المكلف كالقدرة
فأما ما ليس كالوصلة مما تحتاج إليه العبادة فان العبادة المفتقرة إليه ضربان أحدهما إقدام على الفعل والآخر إخلال بفعل أما الأول فضربان أحدهما أن يكون إنما لم يتم من دون غيره لأجل الالتباس نحو أن يترك الإنسان صلاة من جملة الخمس لا يعرفها بعينها فيلزمه فعل الخمس لأنه لا يتمكن مع الالتباس أن يتيقن إتيانه بالمنسية إلا بفعله الكل والآخران أن لا يمكن استيفاء العبادة إلا بفعل آخر لأجل التقارب نحو ستر جميع الفخذ لأنه لا يمكن إلا مع ستر بعض الركبة وغسل جميع الوجه لا يمكن إلا مع غسل يسير من الرأس وأما إذا كانت العبادة إخلالا بفعل ولا يمكن إلا بغيره فهو أن يكون ما يلزم
الإخلال به ملتبسا بغيره وهو ضربان أحدهما أن يكون قد تغير في نفسه والآخر لا يكون قد تغير في نفسه فالأول نحو اختلاط النجاسة بالماء الطاهر وقد اختلف الناس في ذلك فمنهم من حرم استعمال الماء المتيقن حصول النجاسة فيه على كل حال ولم يجعلها مستهلكة ومنهم من جعلها مستهلكة واختلفوا في الأمارة الدالة على استهلاكها فمنهم من قال هي تغير الماء ومنهم من قال هي كثرة الماء واختلف هؤلاء فمنهم من قدر الكثرة بالقلتين ومنهم من قدرها بكر وغير ذلك فأما ما لا يتغير مع الالتباس فإنه يشتمل على مسائل
منها أن يلتبس الإناء النجس بالإناء الطاهر وقد اختلف في ذلك فمنع قوم من استعمالها تغليبا للحظر لأجل مساواة الطاهر النجس في العدد وقال قوم بالتحري والعمل على غلبة الظن فإذا غلب على الظن نجاسة أحدهما جرى ذلك مجرى العلم في أن أحدهما قد أمكن استعماله من دون المحرم
ومنها أن يوقع الإنسان الطلاق على امرأة من نسائه بعينها ثم تذهب عليه عينها قال قاضي القضاة الأقوى عندي أن تحرم الكل لأن التحريم قد كان تعين فلا يؤمن إذا استمتع بواحدة منهن أن تكون هي المطلقة
فهذه جملة الأقسام وقد ذكرت في الشرح الأشياء التي يتبع بعضها أحكام بعض وقد ذكرها قاضي القضاة في شرحه وعدلت عن ذكرها ها هنا لأنها بالكلام أشبه
فأما الكلام في الفصل الثاني فهو أن ما لا يتم العبادة إلا معه ضربان أحدهما لا يمكن المكلف تحصيله كالقدرة والآخر يمكن تحصيله فالأول لا يدل الأمر بالعبادة على وجوبه لأنه غير ممكن فعله والأمر من الحكيم لا يتوجه بما لا يمكن ولا يتوجه إلى العبادة إلا بشرط حصول القدرة لأنه إن كان يوجد مع فقدها كان أمرا بما لا يطاق والثاني على ضربين أحدهما أن يكون الأمر بالعبادة ورد مشروطا بحصول ما يفتقر إليه العبادة نحو أن يقال
للمكلف اصعد السطح إن كان السلم منصوبا وهذا يقتضي وجوب الصعود إن كان السلم منصوبا لأن الأمر تناول المكلف بهذا الشرط وقد حصل الشرط ولا يتناول المكلف مع فقد الشرط فلم يوجب عليه صعودا كساير ما لا يتناوله الأمر وإذا لم يوجب عليه الصعود لم يوجب عليه نصب السلم والضرب الآخر أن يرد الأمر مطلقا نحو أن يقال للمكلف اصعد السطح فان هذا الأمر يوجب عليه الصعود وتقديم نصب السلم يدل على ذلك أن الأمر المطلق يقتضي إيقاع الفعل لا محالة متى أمكن إيقاعه وإذا اقتضى ذلك اقتضى إيقاع ما يحتاج إليه الفعل وإنما قلنا إن المطلق يقتضي إيقاع الفعل على كل حال لأنه لو كان مقيدا بوقت نحو أن يقال اصعد السطح في هذا الوقت فانه يجري مجرى أن نقول له لا يخرج هذا الوقت إلا وقد صعدت السطح على كل حال متى تمكنت الصعود إذ ليس في لفظ الأمر ذكر الشرط ولو قيل له ذلك لزمه الصعود على كل حال وإنما قلنا إن هذا يقتضي وجوب نصب السلم لأنه لو لم يجب نصب السلم بل كان مباحا أن لا ينصبه لكان الأمر كأنه قال له مباح أن لا تنصب السلم وواجب عليك مع فقد السلم وغيره أن تصعد وذلك تكليف ما لا يطاق
فإن قيل ليس يخلو الأمر بالصعود إما أن يكون مشروطا بنصب السلم أو غير مشروط به فإن كان مشروطا به فهو قولنا ويجب إذا لم يكن السلم منصوبا أن لا يكون متوجها إلى المكلف ولا يلزمه نصبه وإن كان غير مشروط بوجود السلم فذلك تكليف ما لا يطاق والجواب أنا لا نعقل من قولهم إن الأمر بالصعود مشروط بنصب السلم إلا أنه يتناول المأمور عند نصب السلم ولا يتناوله إذا لم يكن السلم منصوبا وهذا موضع الخلاف لأنا نقول إن الأمر يتناول المأمور سواء كان السلم منصوبا أو غير منصوب وليس في ذلك تكليف ما لا يطاق لأنا نقول إن الأمر اقتضى وجوب نصب السلم وهو ممكن للمكلف ولولا صحة ما ذكرناه لكان كل من أمر غلامه بحاجة في السوق وهو في البيت أن يكون إنما أمره بذلك إن حصل في أقرب
الأماكن من مكان تلك الحاجة إن كانت القسمة لا تخلو مما ذكروه
فإن قالوا ليس في لفظ الأمر ذكر الإيجاب غير المأمور به فلم أوجبتموه قيل لأن وجوب المأمور به اقتضى وجوبه كما أوجبنا التسبب وإن كان الأمر بالمسبب لا ذكر للسبب فيه وكما أوجبنا ستر بعض الركبة وإن لم يكن له ذكر في الأمر بستر الفخذ
فإن قيل هلا شرطتم الأمر بحصول الصفة التي يحتاج إليها الفعل حتى لا يلزم وجوب تحصيل تلك الصفة قيل لأن اشتراط ما ذكرتم يمنع من ثبوت وجوب المأمور به في بعض الحالات وعلى بعض الوجوه بأن لا تكون الصفة حاصلة ول يلزم تحصيلها ونحن قد بينا أن ظاهر الأمر يقتضي وجوب المأمور على كل حال فاشتراط ما ذكرتم فيه ترك للظاهر
فإن قالوا لستم بأن تتمسكوا بظاهر الأمر في إيجاب المأمور به على كل حال وتتركوا ظاهره في إيجاب ما لا ذكر له في الأمر بأولى من أن تتمسكوا بظاهره في نفي وجوب ما لا ذكر لإيجابه فيه وهو ترك ظاهر الأمر في نفي اشتراط شرط يمنع من وجوب المأمور به في بعض الحالات قيل قد سلمتم وبينا نحن أن ما تفعلونه أنتم ترك لظاهر الأمر فأما إيجابنا لما لا ذكر له في الأمر فليس بترك لظاهر الأمر فيقع بيننا وبينكم المساواة في ترك إحدى الظاهرين واستعمال الآخر لأن ما لا يتم المأمور به إلا معه كما أنه لا ذكر لإيجابه في الأمر فإنه لا ذكر لنفي وجوبه فيه ومن أوجب ما لا يمنع اللفظ من وجوبه ولا يقتضي صريحه وجوبه لم يكن تاركا لظاهر اللفظ ألا ترى أن إثبات الربا ليس بترك لآية الدين لما لم ينفه ولم يتعرض له أصلا فأما ظاهر قوله افعل في هذا الوقت فانه يقتضي أن يفعل فيه على كل حال متى أمكنه فعله فيه على كل حال فالقول بأنه مشروط شرطا إن لم يكن حاصلا فإنه لا يلزمه الفعل إسقاط الوجوب في كل حال مع أن ظاهر القول اقتضاه
باب في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده دال على قبحه أم لا
ذهب قوم إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وخالفهم أخرون على ذلك وإليه ذهب قاضي القاضة واصحابنا والخلاف في ذلك إما في الاسم وإما في المعنىفالخلاف في الاسم أن يسموا الأمر نهيا على الحقيقة وهذا باطل لأن أهل اللغة فصلوا بين الأمر والنهي في الاسم وسموا هذا أمرا وسموا هذا نهيا ولم يستعملوا اسم النهي في الأمر فإن استعملوه فيه فقليل نادر
والخلاف في المعنى من وجهين أحدهما أن يقال إن صيغة لا تفعل وهو النهي موجودة في الأمر وهذا لا يقولونه لأن الحس يدفعه والآخر أن يقال إن الأمر نهي عن ضده في المعنى من جهة أن يحرم ضده وهذا يكون من وجوه
منها أن يقال إن صيغة الأمر تقتضي إيقاع الفعل ونمنع من الإخلال به ومن كل فعل يمنع من فعل المأمور به فمن هذه الجهة يكون محرما لضد المأمور به وهذا قد بينا صحته من قبل
ومنها أن يقال إن الأمر يقتضي الوجوب لدليل سوى هذا الدليل فاذا تجرد الأمر عن دلالة تدل على أن أحد أضداد المأمور به يقوم مقامه في الوجوب اقتضى قبح أضداده إذ كل واحد منها يمنع من فعل المأمور به وما منع من فعل الواجب فهو قبيح وهذا الوجه أيضا فهو صحيح إذا ثبت أن الأمر يدل على الوجوب
ومنها أن يقال إن الأمر يدل على كون المأمور به ندبا فيقتضي أن الأولى أن لا يفعل ضده كما أن النهي على طريق التنزيه يقتضي أن الأولى أن لا يفعل
المنهي عنه وهذا لا يأباه القائلون بأن الأمر على الندب غير أنه لو سمي الأمر بالندب نهيا عن ضد المأمور به لكنا منهيين عن البيع وسائر المباحات لأنا مأمورون بأضدادها من الندب
ومنها أن يقال إن الأمر بالشيء يقتضي حسنه أو كونه ندبا وحسن الشيء يقتضي قبح ضده وأن الأمر يدل على إرادة الآمر للمأمور به وإرادة الشيء كراهة ضده أو تتبعها لا محالة كراهة ضده إما من جهة الحكمة أو الصحة والحكيم لا يكره إلا القبيح وهذا كله باطل بالنوافل لأنها حسنة ومراده ليست اضدادها قبيحة ولا مكروهة
فإن قالوا صيغة افعل إذا تعلقت بالنوافل لم تكن أمرا على الحقيقة فلهذا لم تكن نهيا عن أضدادها قيل إنما كلامنا على قولكم إن حسن الشيء وتعلق الإرادة به يقتضي قبح ضده وكونه مكروها وهذا منتقض بالنوافل سواء سميتم ما تعلق به أمرا أم لا ثم يقال لهم فاذا كان ما تعلق بالنوافل ليس بالأمر فما الأمر فان قالوا ما دل على الوجوب كانوا قد تركوا هذا القسم وعدلوا إلى ما تقدم فأما النهي عن الشيء فانه دعاء إلى الإخلال به فيجب كونه في معنى الأمر بما لا يصح الإخلال بالمنهي عنه إلا معه فإن كان للمنهي عنه ضد واحد ولا يمكن الانصراف عنه إلا إليه كان النهي دليلا على وجوبه بعينه وإن كان له اضداد كثيرة ولا يمكن الانصراف عنه إلا إلى واحد منها كان النهي في حكم الأمر بها أجمع على البدل
باب في الأمر المطلق هل يقتضي الفعل مرة واحدة أو يقتضي التكرار
ذهب بعض الناس إلى أن ظاهره يفيد التكرار وقال الأكثرون إنه لا يفيده وإنما يفيد إيقاع الفعل فقط وبالمرة الواحدة يحصل ذلك والدليل على ذلك أن السيد إذا أمر غلامه بالدخول إلى الدار أو يشترى اللحم لم يعقل منه التكرار ولو ذمه على تركه تكرار الدخول لامه العقلاء ولو كرر الدخول اليها جاز أن يلومه ويقول له إني لم آمرك بتكرار الدخول إليها
فان قيل أليس الرجل إذا قال لغيره أكرم فلانا أو أحسن عشرته عقل منه التكرار قيل له المعقول من قول القائل لغيره أحسن عشرة فلان لا تسيء عشرته ولهذا يقال لمن لا يسيء عشرته على غيره إنه يحسن عشرته والنهي يفيد الاستدامة وأيضا فإن هذا الكلام يعقل منه فعل الإكرام والتعظيم ومعلوم أنه لم يأمره باكرامه وتعظيمه إلا لأنه عنده يستحق ذلك فمتى لم يعلم زوال العلة الموجبة لاستحقاقه وجب دوام ذلك فبهذه القرينة يعلم دوام الإكرام لا لمجرد الأمر وايضا فان قولنا عشرة يفيد جملة من الأفعال لا فعلا واحدا ألا ترى أن من رأيناه يعامل غيره بعمل واحد جميل لا يوصف بأنه حسن العشرة وإنما يوصف بذلك إذا عرفنا أن ذلك من عادته وأنه يكرر هذا الفعل وإذا كان اسم العشرة يفيد جملة من الأفعال والأمر بحسن العشرة أمر بجملة من الأفعال حسنة وليس أسم العشرة يتناول فعلا واحدا حتى إذا استفيد من قولنا أحسن عشرة فلان أفعال كثيرة وجب أن يكون قد دل على تكرار فائدته
دليل آخر قول القائل لغيره ادخل الدار معناه كن داخلا لأن من دخل الدار يوصف بأنه داخل وبدخلة واحدة يوصف بانه داخل فكان ممتثلا للامر وكان الأمر عنه ساقطا كما أن قوله اضرب رجلا يسقط عنه إذا ضرب رجلا واحدا لأنه بذلك يوصف بأنه ضارب لرجل فإن قيل وهو بالدخلة الثانية يوصف بأنه داخل أيضا فهلا دخلت تحت الأمر أو توقفتم في دخولها فيه قيل بالدخلة الأولى يكون داخلا على الكمال لأنه يكون داخلا على الإطلاق فكمل بها فائدة الأمر وإنما الدخلة الثانية تكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها وإن وقع عليه اسم دخول فلم يدخل تحت الأمر إلا بلفظ
تكرار أو عموم كما أنه إذا قال له اضرب رجلا فضرب فإنه بضرب واحد يكون مستكملا لفائدة الأمر وإنما ضرب رجل آخر تكرار لفائدة الأمر بعد استكماله فلم يلزم بالأمر المطلق وإنما يلزم بلفظ عموم ولا لفظ للعموم ها هنا
فان قيل ما أنكرتم أن يكون قوله اضرب معناه افعل الضرب ولو قال ذلك لوجب أن يفعل جنس الضرب لأن لام الجنس تقتضي استغراق الجنس قيل إنما أنكرنا ذلك لأن قوله اضرب تصريف من ضرب لا من الضرب لأنه ليس فيه ذكر الألف واللام يبين ذلك أنه لو كان قوله اضرب معناه افعل الضرب لكان قوله زيد ضرب معناه افعل الضرب فكان يجب أن يفهم منه تكرار الضرب واستغراق الجنس ومعلوم أن المفهوم من ذلك ضرب مرة ولا نعلم به ماذا عليها فيجب أن نعلم بالأمر وجوب المرة ولا نعلم به وجوب ما زاد عليها فإن قيل فيجب أن يشكوا فيما زاد عليها قيل لا يجب ذلك لأن الأمر إن لم يفده كفى في نفيه أن لا يدل دليل آخر عليه ولو دل دليل آخر عليه لكنا إنما استفدناه بغير الأمر
احتج المخالف بأشياء
منها وجود أوامر في القرآن على التكرار والجواب أن ذلك لا يدل على أنه عقل التكرار من ظاهرها كما لم يدل وجود الفاظ عامة في القرآن لم يرد بها العموم على أنها ما وضعت له على أن في القرآن إيجاب الحج وليس وجوبه متكررا
ومنها قولهم لو لم يفد الأمر التكرار لما اشتبه على سراقة ذلك مع أنه عربي حين قال للنبي عليه السلام أحجتنا هذه لعامنا أو للأبد والجواب أنه ليس في الخبر دليل على أن سبب سؤاله اشتباه ذلك عليه وأيضا فلو كان الإيجاب يفيد التكرار لما اشتبه على سراقة فكان لا يسأل عن ذلك وليس
يمتنع أن يكون إنما سأل لأن الأمر في اقتضائه المرة والتكرار مشتبه بل لأنه ظن أن الحج مقيس على الصلوات والصيام والزكاة فأراد إزالة هذا الاشتباه وقول النبي صلى الله عليه و سلم لو قلت نعم لوجبت دليل على أن وجوب التكرار لم يستفد من الإيجاب بل من قوله صلى الله عليه و سلم وجوابه
ومنها قولهم إن الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان فاقتضى إيقاع الفعل في جميعه والجواب أن القائلين بالفور يجعلون الأمر بأقرب الأوقات إليه أخص فمنهم من يقول إذا لم يفعل المكلف في أقرب الأوقات إليه لم يلزمه الفعل إلا بدليل آخر ومنهم من يقول يلزمه الفعل بالأمر لا لأن الأمر نعقله بالأوقات على سواء بل لأنه يجري مجرى قول القائل افعل في الوقت الأول فان لم تفعل ففي الثاني فان لم تفعل ففي الثالث والأمر عندهم يتعلق بالأوقات على سواء بل لأنه يجرى مجرى قول القائل افعل في الوقت الأول فأن لم تفعل ففي الثاني فأن لم تفعل ففي الثالث والأمر عندهم يتعلق بالأوقات كلها على هذا الترتيب وأما النافون للفور فانهم يقولون لا اختصاص للامر بالأوقات وإذا لم يكن له بها اختصاص صح إيجاب الفعل في جميعها على البدل وعلى الجمع لأن الاختصاص زائل في الحالين فلم يكن فقد الاختصاص طريقا إلى أحدهما
ومنها قولهم لو لم يفد الأمر التكرار لما صح ورود النسخ عليه ولا الاستثناء لأن ورود النسخ على المرة الواحدة يدل على البداء وورود الاستثناء عليها يكون نقضا والجواب أن النسخ لا يجوز وروده عليه إلا أن يدل الدليل على أن المراد بالأمر التكرار فيبين النسخ أن بعض المرات لم يرد وكذلك الاستثناء لا يجوز وروده على الأمر على قول من قال بالفور وأما من لم يقل بالفور فانه يجوز أن يرفع الاستثناء الفعل في بعض الأوقات التي المأمور مخير بين إيقاع المرة فيها وقد قال الشيخ أبو عبد الله رحمه الله إن ورود النسخ والاستثناء على الأمر يدلان على أنه قد أريد به التكرار
ومنها قولهم لو لم يفد الأمر إلا مرة واحدة لم يكن لقول القائل لغيره افعل مرة معنى إذ ذلك معقول من الأمر من غير تقييد والجواب أن المقتضى لذلك هو المقتضى لحسن التأكيد في الكلام وهو ما يفيد من قوة العلم أو الظن وأيضا لو اقتضى التكرار لم يحسن أن يقول افعل متكررا
ومنها قولهم لو أفاد الأمر فعل مرة لما حسن استفهام الآمر فيقال له اردت بأمرك فعل مرة أو أكثر لأن الأمر قد دل على المرة بالأمر والجواب أنه يحسن ذلك طلبا لتأكيد العلم أو الظن أو لأن المأمور عارضه شبهة جوز لأجلها التكرار وسنشبع الكلام في ذلك عند الكلام في العموم إن شاء الله
ومنها قولهم لو أفاد الأمر مرة فلم يفعل المكلف الفعل في الأول لاحتاج في فعله في الثاني إلى دليل والجواب أن ذلك إنما يلزم من قال إن الأمر يقتضي فعل مرة واحدة على الفور وهذا كلام على القائلين بالفور وسيجيء في موضعه ومن لم يقل بالفور لا يلزمه ذلك
ومنها قولهم إن الاحتياط يقتضي تكرار المأمور به لأنه لا ضرر على المكلف فيه ولا نأمن الضرر في ترك التكرار لتجويزه أن يكون الأمر على التكرار والجواب أن المتكلم إذا علم أن الأمر ليس على التكرار أمن الضرر لفقد التكرار ومتى أهمل النظر في ذلك لم يأمن الضرر في اعتقاد وجوب التكرار وإيقاع التكرار بنية الوجوب
ومنها أن الأمر ضد النهي وكالنقيض له فلو كان الأمر يفيد إيقاع الفعل مرة واحدة لكان النهي يفيد الإخلال بالفعل مرة واحدة ولما كان النهي يفيد الانتهاء عن الفعل ابدا كان الأمر يفيد إيقاع الفعل ابدا والجواب أن النهي كالنقيض للامر على ما ذكروه لأن قول القائل لغيره كن فاعلا موجود في قوله لا تكن فاعلا وإنما زاد عليه لفظة النفي وهو لا وزاد عليه
التاء فجرى مجرى قوله زيد في الدار وليس زيد في الدار وكون النهي كالنقيض للامر يوجب أن يفيد في الفعل نقيض فائدة الأمر في الفعل فاذا كان قولنا افعل يقتضي أن نفعل في زمان ما أي زمان كان فنفي هذا ونقيضه هو أن لا نفعل في شيء من الأزمان لأنه إن لم يفعل اليوم وفعل غدا كان ممتثلا للامر ولا يجوز أن يكون ممتثلا للامر والنهي معا مع أنهما نقيضان فصح أن كون الأمر مفيدا لمرة غير معينة يقتضي أن يكون نقيضه يرفع المرة في كل الأزمان ألا ترى أن قول القائل في الدار رجل يقتضي أن فيها رجل غير معين فاذا قال ليس في الدار رجل كان نقيضا له ولا يكون نقيضا له إلا بأن يرفع كل الرجال لأنه إن رفع بعض الرجال دون بعض كان مقتضى قوله في الدار رجل ألا ترى أنه يصدق القائل في الدار رجل إذا كان فيها هذا الرجل فكذلك النهي مع الأمر وأما كون النهي مفيدا لإخلال بالفعل أبدا فهو حجتنا في اقتضاء الأمر للفعل مرة واحدة لأن النهي إذا أفاد الانتهاء على العموم فنقيضه من الإثبات يقتضي مرة واحدة غير معينة كما إن قولنا ليس في الدار رجل لما أفاد نفي كل الرجال كان قولنا في الدار رجل يفيد إثبات رجل غير معين لأنه بذلك يكون مناقضا للنفي فكذلك إذا كان قولنا لا تدخل الدار يفيد لا تدخلها أبدا فنقيض ذلك أن يدخلها ولو مرة واحدة لأنه بذلك يخرج من كونه غير داخل إليها أبدا وإذا كان كذلك وكان الأمر يقتضي النهي اقتضى الفعل مرة واحدة
وقال قاضي القضاة العادة فرقت بينهما لأن الإنسان إذا قال لعبده ادخل الدار عقل من ذلك مرة واحدة وإذا قال له لا تدخل الدار عقل منه التأبيد وهذا فرق ليس فيه ذكر العلة المفرقة بينهما وقال أيضا إن الأمر بالضرب يفيد أن يكون المأمور ضاربا بالمرة الواحدة يتم ذلك والنهي عن الضرب يفيد أن لا يكون ضاربا ولا يتم ذلك إلا مع التأييد
ولقائل أن يقول ثبتوا أن المرة الواحدة تتم فائدة الأمر ولا تتم فائدة النهي حتى يصح ما ذكرتم وعلى أن هذا الكلام هو ابتداء دلالة وليس فيه بيان أن ما ذكروه من أن النهي يقتضي الأمر ولا يقتضي تكرار المأمور به وفرق بينهما أيضا بأن النهي يقتضي قبح المنهي عنه والقبيح يجب الانتهاء عنه أبدا والأمر يقتضي المأمور به والحس يجوز تركه وأجاب عن ذلك بأن القبيح في وقت لا يجب كونه قبيحا في غيره فإن كان ظاهر النهي لا يقتضي الانتهاء أبدا وإنما يقتضي الانتهاء في وقت ما فإنا لا نعلم قبحه في كل وقت ولو كان ما قبح في وقت قبح في كل الأوقات لزم أن يكون النهي على التأبيد بهذه الدلالة لا بظاهره وأيضا فان الأمر إذا اقترن به الوعيد كان على الوجوب فان كان القبيح يلزم الامتناع منه أبدا فالواجب لا يجوز الإخلال به أبدا
وقد فرق بينهما بأن الأمر يقتضي الإقدام على الفعل وتكرار الإقدام عليه أبدا لا يمكن لأنه يقطع عن الأغراض والنهي يقتضي الكف عن الفعل والكف أبدا عنه ممكن وهذا ليس بفرق من جهة المواضعة وليس يمتنع أن يضعوا لما لا يمكن لفظه ألا ترى أن قولهم افعل أبدا ولا تخل به ولا تتشاغل بغيرها أمر يكر به موضوع للتأبيد الذي لا يمكن وعلى أنه لا يمتنع أن يكون الأمر يفيد من التكرار ما يمكن
وقد فصل بينهما بأنه يكفي في مخالفة النهي فعل مرة واحدة ولا يكفي في امتثاله إلا الكف أبدا ويكفي في امتثال الأمر فعل مرة ولهذا يوصف المأمور بأنه ممتثل الأمر إذا فعل المأمور به مرة واحدة والجواب أنه إن أمكن أن يبين ذلك قبل العلم بأن الأمر ليس على التكرار والنهي على التكرار فالكلام صحيح ويجب بيان ذلك ليصح الفرق وإلا فللسائل أن ينازع في وصف المكلف بأنه ممتثل للأمر إذا فعل مرة واحدة
وفرق بينهما بأن المأمور لا يقال له ائتمر بالمرة الثانية ويقال للمنهي وقد انتهى بالانتهاء عن الفعل مرة وثانية فعلمنا أن الأمر ليس على
التكرار وأن النهي يفيده وللمخالف أن يقول إني أصف المأمور بالائتمار كلما كرر الفعل كما قلتموه في النهي
وفرق بينهما بأن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم قالوا وذلك يدل على أن الأمر ليس على التكرار والجواب أن هذا يدل على ان الأمر خلاف النهي في شرط الاستطاعة وليس بدليل على ان ظاهر أحدهما التكرار دون الآخر بل لو قيل إنه يدل على أن ظاهرهما التكرار وأن التكرار يسقط عن المأمور لفقد الاستطاعة ولا يسقط عن المنهي لكان أولى والصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم عني بالاستطاعة المشقة دون القدرة لأن القدرة شرط في امتثال الأمر والنهي وإنما خص الأمر باشتراط هذه الاستطاعة لأن الأفعال يظهر فيها من المشقة ما لا يظهر في كثير من التروك
باب في أن الأمر المعلق بصفة أو بشرط هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرار
كل واحد منهما أم لاأعلم أنه ينبغي أن نذكر أولا الشرط والصفة وأحكامهما ثم نذكر ما فائدة الأمر المعلق بهما فنقول إنا قد نصف الشيء بأنه شرط ونعني أن عليه يقف تأثير المؤثر سواء ورد بلفظ الشرط أو لم يرد بلفظ الشرط وذلك نحو الإحصان الذي يقف عليه تأثير الزنا في وجوب الرجم وقد نعني أنه وارد بلفظ الشرط سواء كان شرطا في الحقيقة أو علة مؤثرة فالأول نحو أن يقول سبحانه ارجموا الزاني إن كان محصنا والثاني أن يقول ارجموا زيدا إن كان زانيا وذكر قاضي القضاة أن الشرط هو المعقول الذي يتعلق به المشروط وإذا لم يكن يتعلق به المشروط وهذا يلزم عليه أن تكون العلة شرطا وأيضا إن من لا يعرف الشرط لا يعرف المشروط
فأما الصفة التي يتعلق الحكم بها فهي في هذا الموضع ما علق به الحكم من غير أن يتناوله لفظ تعليل ولا لفظ شرط نحو قول الله سبحانه فتحرير رقبة مؤمنة ونحو قوله سبحانه والسارق والسارقة
وذكر قاضي القضاة أن الشرط يجب اختصاصه بأمور ثلاثة
أحدها أن يكون متميزا من غيره وهذا لا بد منه ليتمكن المكلف من إيقاع الفعل عنده
والثاني أن يكون مستقبلا لأن العبادة المعلقة بالشرط مستقبلة فان قيل أليس قد يقول الإنسان لغيره ادخل الدار إن كان زيد قد دخلها بالأمس قيل إذا قال ذلك كان شرط دخوله علمه بعد الأمر بأن زيدا قد كان دخلها
وأحدها أن يكون الشرط ممكنا وهذا لا بد منه لأنه إن لم يكن ممكنا وكلف المأمور الفعل المشروط على كل حال كان قد كلف ما لا يطيقه وبطل فائدة الشرط وإن كلف عند الشرط ولم يكلف عند فقده كان قد علق المأمور به على شرط يعلم الآمر أنه لا يحصل وهذا عبث
وأما الكلام في المسألة فنقول قد اختلف الناس فيها فكل من جعل الأمر المطلق مفيدا للتكرار قال إن الأمر المقيد بصفة أو شرط يفيده أيضا إذا تكرر الشرط والصفة ومن نفي اقتضاء مطلق الأمر لذلك اختلفوا فمنهم من جعله مفيدا للتكرار إذا تكرر الشرط والصفة وعند أكثر الفقهاء أنه لا يفيد ذلك وعندنا ان الشرط الذي يقف عليه تأثير المؤثر لا يجب بتكراره تكرار المشروط فأما ما جاء على لفظ الشرط فانه لا يتكرر المأمور به بتكراره أيضا إلا أن يكون علة وكذلك المعلق بصفة
ودليلنا أنه لو وجب التكرار لم يخل إما أن يكون المفيد لوجوبه هو الأمر أو الشرط والصفة وقد بان في الباب المتقدم أن الأمر لا يفيد ذلك ولو أفاده الشرط لم يخل إما أن يفيده لفظا أو معنى ومعلوم أنه ليس في قولنا إن و إذا لفظ التكرار ولو أفاده من جهة المعنى لكان إنما يفيده من حيث كان الشرط علة وهذا باطل لأن الشرط عليه يقف تأثير المؤثر فلا يمتنع أن يتكرر الشرط ولا يتكرر المؤثر فلا يتكرر الحكم وإذا ثبت أن الأمر لا يقتضي إلا مرة واحدة والشرط لا يقتضي تكرارها لم يستفد من مجموعهما إلا تخصيص تلك المرة بالشرط
ويمكن أن نبتدىء الدلالة فنقول إن الشرط عليه يقف تأثير المؤثر وليس يمتنع أن يتكرر الشرط ولا يتكرر المؤثر فلا يتكرر الحكم فان قيل فإذا جوزتم أن يكون ما ذكر بلفظ الشرط مؤثرا في الحكم فجوزوا التكرار وقفوا فيه ولا تقطعوا على نفيه قيل إن لفظ الشرط لا يدل على أن ما دخل عليه علة فلو كان علة لدل الله عليها فاذا لم يدل عليها قطعنا على أنه ليس بعلة
دليل آخر الخبر المعلق بالشرط لا يقتضي تكرار المخبر عنه بتكرار الشرط فكذلك الأمر المعلق بشرط وقد بينا الجمع بينهما في الباب الأول ومعلوم أن الإنسان إذا قال زيد سيدخل الدار إن دخلها عمرو وقد دخلها عمرو فدخلها زيد يعد صادقا وإن تكرر دخول عمرو ولم يتكرر دخول زيد
دليل آخر المعقول في الشاهد من تعلق الأمر بالشرط فعل مرة وإن تكرر الشرط ألا ترى أن الإنسان لو قال لعبده اشتر لحما إن دخلت السوق لم يعقل منه التكرار وإن تكرر منه الدخول ولذلك قال الفقهاء إن الرجل إذا طلق امرأته بقوله إن دخلت الدار أو أمر وكيله أن يطلقها إن دخلت الدار لم يتكرر الطلاق بتكرار الدخول
احتج المخالف بأشياء
منها أنه وجد في كتاب الله سبحانه أوامر متعلقة بشروط وصفات وتكرر مأمورها بتكرر الصفات نحو قول الله إذا قمتم إلى الصلاة ونحو قوله والسارق والسارقة والزانية والزاني والجواب أنه إنما عقل التكرار بدليل لا بهذه الآيات وأيضا فإنما علم تكرار الحد بتكرار الزنى لأن الزنى والسرقة علتان في الحد والعلة يتبعها حكمهما كلما حصلت وأيضا فمعلوم باضطرار من الدين تكرر الحد بتكرار ذلك
ومنها تشبيههم الشرط بالعلة في وجوب تكرار الحكم بتكرارها ويقوون ذلك بأن الشرط آكد من العلة لأن الشرط ينتفي الحكم بانتفائه ولا ينتفي معلول العلة بانتفائها والجواب أن الشرط عليه يقف تأثير المؤثر وليس يلزم أن يتكرر معه المؤثر حتى يتكرر المشروط بتكراره فأما إذا قال الله سبحانه هذا واجب لعلة كذا أو لأجل كذا فإن الظاهر أن ذلك هو المؤثر في الوجوب لا غير ولا يجوز أن يشرط فيه شرطا إلا بدلالة فإذا لم تدل دلالة على اشتراطه لم يشرطه فوجب تكرار الحكم بتكرار العلة لأنها تحصل بيانا على الحد الذي حصل اولا وإنما جاز وجود الحكم مع فقدها لأنه يجوز أن يخلفها علة أخرى والشرط أيضا يجوز أن يخلفه شرط آخر فاستويا في هذه الجهة وقد فصل قاضي القضاة بين الشرط والعلة بأن العلة دلالة على الحكم والدليل يتبعه الحكم متى وجد وأما الشرط فقد يجوز وجود مثله وليس بشرط ألا ترى أن من طلق امرأته بشرط دخول الدار لم تكن دخلتها الثانية شرطا في الطلاق
ومنها قولهم إن الأمر المعلق بالشرط لا اختصاص له بالشرط الأول من دون أمثاله من الشروط فلزم الفعل عندها كلها لفقد الاختصاص وفي ذلك تكرار المأمور به والجواب أن من قال بالفور يجعل الأمر بالشرط الأول من
الاختصاص ما ليس له بغيره فلا يلزمه الكلام وأما من لم يقل بالفور فيه فينبغي أن يرتب الجواب على مذهبه هكذا ليس يخلو الشرط إما أن لا يغلب على الظن تجدد أمثاله والمأمور متمكن أو يغلب على الظن تجدده والمأمور متمكن فالأول نحو أن يقول القائل لغيره أعط زيدا درهما إذا دخل الدار ولا يغلب على الظن إذا دخل الدار أنه يدخلها مرة ثانية فمتى كان كذلك لزمه دفع الدرهم إليه عند الدخلة الأولى لأنها متحققة حصولها ويجوز أن لا تحصل الدخلة الأخرى ومثال الثاني أن يقول له أعط زيدا درهما إذا طلعت الشمس ومعلوم أنه إذا كان المأمور سالما فان الظن يقوم بسلامته مع طلوع الشمس في غد وفي بعد غد وإذا كان كذلك كان مأمورا بالعطية عند طلوع الشمس في غد وفي بعد غد وفي كل يوم يغلب على الظن تمكنه فيه من العطية على البدل ويكون فقد الاختصاص قد اقتضى تعلق المأمور به بالشروط كلها على البدل ويمكن أيضا أن يقال إن العطية تجب بالشرط الأول فقط لأن قولنا أعط زيدا درهما إذا طلعت الشمس المراد به تعليق العطية بطلوع يزول معه غروبها ومعلوم أن غروبها عند هذا الكلام ليس هو غروبها من الليلة الثانية والثالثة وإذا كان كذلك فطلوعها الذي يزول معه غروبها عنا في هذه الليلة هو طلوعها من الغد فقط وهذا هو الذي يفقده الناس فوجب انصراف ذلك إليه وكذلك القول في جمع الشروط المتجددة وعلى هذا يستوي الجواب على قول أصحاب الفور والتراخي
ومنها قولهم لو لم يقتض الأمر تعليق الوجوب بجميع الشروط لاقتضى تعليقه بأولها وذلك يقتضي أن تكون العبادة إذا فعلت مع الشرط الثاني دون الأول قضاء لا أداء وذلك يحوجها إلى دليل آخر والجواب أن القائلين بأن الأمر يفيد تعليق المأمور به على الشروط كلها على البدل لا يلزمهم ذلك وأما القائلون بأنه يتعلق بالشرط الأول سيجيء القول فيه إن شاء الله وأما قاضي القضاة فانه التزم حاجة العبادة إلى دليل ناتيء في إيقاعها عند الشرط الثاني إذا لم يفعل في الأول وامتنع من تسميتها قضاء وذكر في الشرح أن
الأمر يتعلق بأول الشرط على قول أصحاب الفور ويتعلق بجميعها على قول أصحاب التراخي
ومنها قولهم لو لم يفد الأمر المعلق بالشرط تكرار المأمور إذا تكرر الشرط لما أفاد النهي المعلق بالشرط التكرار يقال لهم ولم زعمتم ذلك فإن قالوا لأن النهي كالنقيض للامر فاقتضى نقيض ما اقتضاه نقيض الأمر في الحال الذي اقتضاه قيل ليس يجب ذلك لأن كونه كالنقيض له يقتضي أن ينفي ما أثبته الأمر في جميع الأحوال كما ذكرناه في النهي المطلق ثم يقال لهم أما القائلون بالفور فقد قلنا إنهم يجهلون الأمر المعلق بشرط يفيد إيقاع المأمور به مع الشرط الأول ويمكن أن يجيء ذلك أيضا على قول أصحاب التراخي على ما ذكرناه فالنهي يقتضي المنع من إيقاعه مع الشرط الأول على التأبيد سواء تجدد شرط ناتيء أو لم يتجدد مثال ذلك أن يقول القائل لا تعط زيدا درهما إن دخل الدار أو إن دخل الدار فلا تعطه درهما فإنه يفيد نفي العطية عند أول دخلة إلى الأبد لأن من نهي غيره عن أن يعطي زيدا درهما إن دخل الدار فليس غرضه المنع من أن يعقب العطية الدخول فقط بل غرضه استدامة نفي العطية إلا أن يتداوله في ذلك فأما من قال بالتراخي فإن الأمر المعلق بالشرط يتعلق بجميع الشروط على البدل على التفصيل المتقدم فان الأمر على قولهم في تقدير أن يقول القائل اعط زيدا درهما إذا طلعت الشمس أما اليوم أو غدا أو بعد غد فيجب أن يفيد النهي المنع من العطية عند هذه الشروط كلها لأنه لما كان نقيض الأمر وجب أن يمنع من العطية عند جميعها لأنه لو لو يمنع من العطية عند الشرط الأول ومنع منها عند الشرط الثاني ما كان مانعا من فائدة الأمر لأن المأمور قد يجوز أن يمتثل الأمر بفعل العطية عند الشرط الأول وفي ذلك اجتماع فائدة الأمر والنهي مع كونهما كالنقيضين وهذا محال
وحكي قاضي القضاة عن الشيخ أبي عبد الله أنه أجاب عن شبهتهم في النهي
بأن العادة تقتضي في النهي المقيد بالشرط أنه يفيد شرطا واحدا وإذا كان مطلقا اقتضى التكرار فسواء بين النهي المقيد بالشرط وبين الأمر قال لأن السيد إذا قال لعبده لا تخرج من بغداد إذا جاء زيد أفاد مرة واحدة وإذا قال لا تخرج من بغداد وأطلق القول أفاد المنع من الخروج على التأبيد فإن قالوا فإذا كان مطلق النهي يفيد التأبيد فيجب أن يكون تقييده بالشرط يفيد قصر المنهي عنه عليه كما قلتموه في الأمر المقيد بالشرط أنه يفيد قصر مقتضى الأمر من المرة عليه وأجاب بأن المطلق من النهي أفاد التكرار في العرف لا في اللغة فلا يمتنع أن يبقى المقيد بالشرط على مقتضى اللغة
باب في الأمر هل يقتضي تعجيل المأمور به أم لا
ذهب الشيخان أبو علي وأبو هاشم إلى أنه لا يقتضي وجوب تعجيل المأمور به في أقرب الأوقات وجوزا تأخير المأمور به عن أول اوقات الإمكان وإلى ذلك ذهب أصحاب الشافعي وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يقتضي تعجيل المأمور به ويحرم تأخيره عن أول أوقات الإمكانوحجة الأولين هي أن الأمر لو اقتضى التعجيل لكان إما أن يقتضيه بلفظة أو بفائدته ومعناه وليس يقتضيه لا بلفظة ولا بفائدته فلم يقتضي الفور
أما الدلالة على أنه لا يقتضيه بلفظه فهي أن قول القائل افعل ليس فيه ذكر وقت متقدم ولا متأخر وإنما يفيد إيقاع الفعل فقط والفعل إذا وجد في الوقت الأول أو الثاني أو الثالث كان موقعا وذلك يقتضي كون المأمور ممتثلا للامر وليس يجوز أن يكون ممتثلا للامر بفعل ما يمنع الآمر منه فجرى مجرى أن يقول الإنسان لغيره افعل في أي وقت شئت في أنه لا يوجب إيقاع الفعل في وقت متقدم وأيضا فإن الإنسان إذا قال لغيره ادفع درهما إلى رجل جاز لذلك الغير أن يدفع أي درهم شاء إلى أي رجل شاء لما لم
يختص الأمر برجل دون رجل ولا بدرهم دون درهم وكذلك يجب أن لا يلزم إيقاعه في وقت معين لأنه لا يختص بوقت دون وقت وأيضا فإن قول القائل لغيره افعل هو طلب للفعل في المستقبل كما ان قوله زيد سيفعل إخبار عن إيقاع الفعل في المستقبل فكما لا يمتنع هذا الخبر من وجود الدخول بعد مدة من الخبر فكذلك الأمر
وأما الدلالة على أنه لا يقتضيه بفائدة فهي أنه لا يمكن أن يقال إنه يقتضيه بفائدته إلا أن يقال إن الأمر يفيد الوجوب ولا يتم الوجوب مع جواز التأخير وهذا لا يصح لأن الفعل قد يجب وإن كان المكلف مخيرا بين إيقاعه في أول الأوقات وفيما بعده ما لم يغلب على ظنه فواته إن لم يفعله فمتى غلب على ظنه ذلك لم يجز له الإخلال وبذلك يفارق النوافل
دليل آخر السيد أذا أمر عبده بشيء ولم يعلم حاجته إليه في الحال ولم يعلم إلا الأمر فقط فانه لا يفهم منه التعجيل وهذه الحجة لا يسلمها الخصم لأنه يقول متى لم يعلم العبد من قصد السيد أنه يبيحه التأخير فانه يعقل من الأمر التعجيل ويستحق العبد الذم إذا لم يعجل المأمور به
واستدل القائلون بالفور بأشياء منها ما يدل على اقتضاء لفظ الأمر لذلك ومنها ما يدل على أن الوجوب المستفاد من لفظ الأمر يقتضي ذلك ومنها أدلة سمعية
أما ما يدل على أن لفظ الأمر يقتضي ذلك فوجهان
أحدهما أن السيد إذا أمر عبده أن يسقيه الماء فهم منه تعجيل سقيه الماء واستحسن العقلاء ذمه على تأخير ذلك من غير عذر فعلمنا أن الأمر يفيد ذلك والمخالف يقول إنما عقل بقرينة وهو علم العبد بأن السيد لا يستدعي ماء ليشرب إلا وهو محتاج إليه في الحال هذا هو الأغلب ولو لم يعلم إلا نفس الأمر لم يفهم ذلك كما أن أصحاب التراخي إذا رجعوا إلى الشاهد في أن
الأمر لا يفيد وجوب التعجيل لم يسلم لهم خصمهم ما يذكرونه من الشاهد وكل منهم يدعي أن ما يقوله خصمه إنما يفهم بقرينة لا بمجرد الأمر فان قال أصحاب الفور إن السيد يعلل ذمه لعبده بأن يقول أمرته بشيء فأخره فلو لم يفد الأمر التعجيل لم يجعل ذلك علة قيل لهم وقد يتعذر البعد أيضا فيقول أمرتني بأن أفعل ففعلت ولم تأمرني بالتعجيل ولا علمت أن عليه في التأخير مضرة
وأما الوجه الآخر فقولهم إن الوقت وإن لم يكن مذكورا في لفظ الأمر فان الفعل لما كان إنما يقع في وقت وجب أن يفيد إيقاعه في أقرب الأوقات إليه كما أن الفاظ العتاق والطلاق والبيع تفيد وقوع أحكامها في أقرب الأوقات إليها والجواب أنه ليس العلة في البيع والإيقاعات ما ذكروه بل العلة في ذلك أن قول القائل بعت وقول المشتري اشتريت إخبار عن الحال برضاهما بانتقال ملك كل واحد منهما عن صاحبه إلى الآخر فجرى مجرى قول القائل تحركت في أنه إخبار عن الحال فوجب أن يحكم في ثاني القبول بانتقال الملك لأن علمنا برضاهما لا يتكامل إلا عند انقطاع القبول ويمكن ان يقال إن الملك ينتقل عند آخر جزء من أجزاء القبول غير أنا لا نضبطه فاذا صح ذلك صار محصول كلامهم انه لما كان الخبر عن الحال يقتضي المأمور به في الثاني في أنه جمع بين شيئين لا يشتبهان وليسوا بذلك أولى ممن حمل الأمر على الخبر عن المستقبل وهو أولى لأن الأمر هو استدعاء الفعل في المستقبل ومعلوم أن الخبر عن المستقبل لا يختص بالثاني فكذلك الأمر فأما قول القائل لامرأته أنت طالق وقوله لعبده أنت حر فهو جار مجرى قوله للمرأة أنت بيضاء أو طويلة في أنه خبر عن الحال ومع أنهما خبران عن الحال فأحكامهما تثبت بالشرع فالواحب اتباع الشرع في كيفية ثبوتهما وقد أثبتهما الشرع من غير تراخ وليس إذا جاء الشرع بذلك وجب أن يكون موضوع الأمر في اللغة الفور وليس يصح الجواب بأن يقال إن حمل الأمر على الإطلاق قياس ولو صح لكان الدال على وجوب التعجيل غير
الأمر لأن المستدل بهذه الدلالة إنما يبين بها أن لفظ الأمر موضوع للتعجيل كما أن الإ يقاع موضوع لإفادة ذلك كما بين اصحاب التراخي قولهم بقياس الأمر على الخبر عن المستقبل ولا يصح أن يفرق أيضا بين الأمر والإيقاعات بأن يقال إن الأمر هو طلب للفعل والفعل إنما يقع في وقت فوجب أن يطلب وقته ما هو وأما الطلاق والعتاق فانهما يفيدان أحكاما لا أفعالا وذلك لأن الأمر كاطلاق في إفادة الألحكام لأن الأمر يفيد وجوب الفعل فصح أن ينظر في وقت الوجوب ما هو والطلاق يفيد تحريم الاستمتاع فصح أن ينظر في وقته هذا التحريم ما هو وكذلك العتاق وقد قيل أيضا لو لم تفد الإيقاعات أحكامها في الثاني لكان وجودها كعدمها وليس كذلك الأمر إذا جعل على التراخي ولقائل أن يقول والأمر لو لم يفد الفور لكان وجوده كعدمه فان قلتم إن وجوده ينفصل من عدمه وإن أفاد التراخي لأنه يفيد وجوب إيقاع الفعل ويكون إيقاعه وإيقاع بدله وهو العزم موقوفا على اختياره قيل لكم فكذلك يفيد نقل الملك في وقت ما ويكون نقله في الثاني أو العزم على نقله وتسليم البيع في الثاني موقوفا على اختياره فان قلتم فبماذا ينقلانه إن كان لفظ البيع نقله في الحال قيل لكم ينقلانه بالتسليم أو بأن يقول كل واحد منهما لصاحبه قد انتقل ملكي إليك في هذه الساعة فإن قلتم أجمعت الأمة على بطلان ذلك في البيع قيل لكم ثبوت هذا الإجماع يقتضي صحة الأصل الذي قسنا عليه وذلك يؤكد صحة القياس وقد قيل أيضا إن الأمر دلالة على وجوب إيقاع الفعل وليس يجب تعجيل مدلول الدلالة وليس كذلك الطلاق والعتاق لأنهما سببان لأحكامهما والسبب إذا تكاملت شرائطه وجب حصول سببه في الحال والجواب أنهما سواء لأن الدلالة قد تدل على حصول مدلولها في الحال وقد تدل على حصوله في المستقبل والسبب قد يكون سببا للحكم في الحال وقد يكون سببا لثبوت الحكم في المستقبل ألا ترى أن البيع المؤجل يكون سببا لانتقال الملك في الثمن في المستقبل فإن قلتم إنما كان البيع المؤجل كذلك لأنه قد ذكر فيه التأجيل وليس كذلك البيع
المطلق قيل لهم فقولوا إن الأمر المقيد بوقت مؤجل يفيد التراخي والمطلق يفيد الحال وعلى أن البيع أيضا دلالة على الرضا والرضا هو السبب في انتقال الملك فقولوا إن الرضا لا يجب أن يتعقب عقد البيع وأيضا فان تكامل شرائط وجوب الحج سبب لوجوبه وهو عندكم على التراخي فان قلتم الوجوب حاصل وإن لم يتضيق قيل لكم فقد بطل قولكم إن المسبب لا يتراخى عن السبب وقد قيل ايضا إن البدل يجب أن يكون بازاء المبدل فاذا وجب انتقال الملك في البدل وجب انتقال الملك في المبدل ولقائل أن يقول ومن أين لكم أن الملك قد انتقل في المبدل حتى تبنوا عليه انتقال البدل وقد قيل إن البيع والإيقاعات تقتضي أحكامها على وجه التأبيد فجرى مجرى النهي في اقتضاء المنع من الفعل على التأبيد وأما الأمر فانه يقتضي فعلا واحدا والجواب أن كون الحكم مما إذا وقع دام لا يمنع من أن ننظر في ابتداء وقوعه هل هو معجل أو متأخر ألا ترى أن البيع المؤجل يقتضي نقل الملك في الثمن في المستقبل وإذا انتقل فيه دام ولا يقتضي البيع انتقال الملك فيه إلى حد وغاية وكون الفعل المستفاد بالأمر واحدا لا يمنع من أن ننظر في وقت لزومه وأن يكون وقت لزومه هو أول الأوقات
واما استدلالهم على الفور بفائدة الأمر فمن وجوه
ومنها أن الأمر قد اقتضى وجوب الفعل في أول أوقات الإمكان بدلالة أنه لو أوقعه المكلف فيه لأسقط الفرض بذلك على نفسه فجواز تأخيره عنه نقض لوجوبه فيه وإيجاب لحوقه بالنافلة فيه والجواب يقال لهم ما معنى قولكم إن الأمر اقتضى وجوب الفعل في أول أوقات الإمكان فان قالوا معناه أنه ألزم فعله فيه ومنع من تأخيره عنه قيل وهل نوزعتم إلا في ذلك وإن قالوا معناه أن المكلف لو فعل المأمور به في ذلك الوقت كان قد اسقط الفرض عن نفسه قيل ولم إذا كان كذلك لا يجوز تأخير الفعل عنه فان قالوا لو جاز تأخيره عنه نقض القول بسقوط الفرض بالفعل في ذلك الوقت
قيل لهم ولم زعمتم ذلك وما انكرتم أن الفرض إنما سقط بايقاع الفعل في الأول لأن الأمر اقتضى إيقاع الفعل فقط وهذا حاصل إذا فعله في الأول وإذا فعله في الثاني فالأمر اقتضى إسقاط الفرض بالفعل في الثاني والثالث من حيث اقتضى إسقاطه بإيقاع الفعل في الأول ويبطل بالكفارات الثلاث لأنه إذا فعل كل واحدة منها سقط الفرض ومع هذا يجوز تأخيرها عنه وقد أجيب عن ذلك بأن جواز تأخير الفعل عن ألأول لا ينقض وجوب الفعل ولا يلحقه بالنافلة لأنه ينفصل عن النافلة بأن النافلة يجوز الإخلال بها اصلا وليس كذلك الفرض لأنه لا يجوز الإخلال به أصلا وهذا غير صحيح لأن المستدل ألزم على جواز التأخير عن الأول بأن يلحق بما هو فعل في ذلك الوقت ولم يلزم أن يلحق بالنوافل على الإطلاق فيفصل بينه وبين النافلة المطلقة وأجاب شيوخنا فقالوا إن الواجب إذا أخر إلى بدل لام ينتقص وجوبه ولم يلحق بالنوافل والفعل إنما يجوز تأخيره عن ثاني الأمر إلى بدل هو العزم على أدائه واستدلوا على كون العزم بدلا بأن الأمر اقتضى إيجاب الفعل ولم يعين الوقت فاذا وجب الفعل في الثاني وجاز مع ذلك تأخيره عنه لم يمكن ذلك إلا مع البدل وقد أجمعوا على أن المأمور يلزمه إذا لم يفعل المأمور به في الثاني أن يعزم على ادائه فيما بعد فقد دل الدليل على وجوب العزم ولم يدل الدليل على وجوب غيره فأثبتناه دون غيره وسنتكلم على هذا الجواب فيما بعد إن شاء الله
ومنها قولهم إن الأمة قد أجمعت على أن الفرض يسقط عن المأمور بايقاع الفعل في ثاني حال الأمر ولم تجمع على إسقاطه إذا فعله بعده فلم يجز تأخيره والجواب يقال لهم ولم إذا لم تجمع على ذلك لم يجز التأخير وما أنكرتم أنه ليس كل ما لم تجمع الأمة عليه فهو باطل لأنه لا يمنع على وجوب صحته دليل غير الإجماع كما أن تحريم التأخير لم تجمع الأمة عليه ولم يمنع من ذلك صحة القول به
ومنها قولهم إن المكلف إذا فعل المأمور به في الثاني سقط عنه الفرض وفعل ما وجب عليه فعلمنا أن الأمر قد تناول ذلك وهذا يمنع من الإخلال به لأنه بالإخلال به يفوت إذ كان ما يقع فيما بعد ليس هو ذلك المأمور به بعينه وإنما هو مثله لأن أفعال العباد تحتص بالأوقات فما يصح أن يوجدوه في وقت لا يصح إيجاده في غيره فلم يجز أن يفوت المكلف ما علم أن التكليف قد تناوله والجواب أن الآمر إنما أوجب ما له صورة مخصوصة من الأفعال ولم يوجب فعلا معينا لأن المكلف لا يميز ذلك فاذا كان كذلك وكان ما يفعله في الوقت الأول وفيما بعده قد اختص بتلك الصورة كان فاعل كل واحد منهما ممتثلا للامر وأيصا فان المخالف يقول لو تناول الأمر الأفعال المختصة بالأوقات لم يمتنع أن يتناول أعيان ما يختص بكل وقت فيجوز ترك ما اختص بالوقت الأول إلى ما يختص بالثاني والثالث لأن كل واحد من ذلك بدل من صاحيه والكلام في أن أفعال المكلف تختص بالأوقات ليس هذا موضعه
ومنها قولهم إن الأمر قد اقتضى الوجوب فحمله على وجوب الفعل في ثاني الأوقات أحوط والجواب أن النافين للفور يقطعون على نفي وجوبه فهم آمنون من المضرة إن أخروا الفعل غير خائفين من ذلك ويقولون طريق الاحتياط أن ننظر هل يقتضي الفور أم لا فان علمنا أنه يقتضيه حملناه عليه وإن لم يقتضه لم نحمله عليه والاحتياط ثابت في كلا القسمين وليس الاحتياط أن نعتقد وجوب التعجيل ونحن لا نأمن أن لا يكون واجبا فنكون قد فعلنا اعتقادا لا نأمن كونه جهلا
ومنها قولهم إن الأمر يتناول الفعل فيقتضي وجوبه ولا يتناول اعتقاد وجوب المأمور به فاذا وجب تعجيل اعتقاد وجوب المأمور به مع أن الأمر ما تناوله فبأن يقضي وجوب تعجيل المأمور به أولى والجواب يقال لهم لم زعمتم أنه إن وجب تعجيل اعتقاد وجوب المأمور به وجب تعجيل المأمور به وما
أنكرتم أن تعجيل الاعتقاد يجب لدليل يخصه لا للأمر وإنما كان يلزم ما ذكرتموه لو وجب ذلك لأجل الأمر فان قالوا الاعتقاد تابع للمعتقد فاذا تعجل الاعتقاد تعجل المعتقد قيل لهم أتعنون أن وجوب تعجيل الاعتقاد تابع لوجوب تعجيل المعتقد فان قالوا نعم قيل لهم لا نسلم ذلك وإن قالوا نعني أن وجوب الاعتقاد تابع لوجوب المعتقد قيل لهم ولم إذا كان كذلك وجب إذا الزم تعجيل الاعتقاد أن يلزم تعجيل المعتقد ثم يقال لهم إن المكلف إذا سمع الأمر بالفعل فلا يخلو إما أن يكون قد سبق له العلم بأن الأمر على الوجوب وأن خطاب الحكيم يجب حمله على موضعه أو لم يسبق له ذلك فإن كان قد سبق له ذلك فهو يعلم وجوب المأمور به في ثاني سماعه الأمر الذي يعلمه صادرا من حكيم ولا يمكنه أن لا يعلم ذلك فلا يصح أن يجب والحال هذه وإن لم يعلم أن الأمر على الوجوب فلا يخلو إما أن يكون قد علم أن ألفاظ الوجوب المطلقة لا تفيد الفور أو لا يعلم ذلك فان علم ذلك فان لم يثبت العزم بدلا يقول إنه لا يلزمه أن يعجل اعتقاد المأمور به ولا النظر فيه لأنه يقول إن لم يكن الأمر على الوجوب فليس يلزمني في الثاني ولا فيما بعده أن أفعل شيئا فلا يلزمني اعتقاد وجوب ذلك الشيء وإن كان الأمر على الوجوب فليس يلزمني أيضا فعل الواجب في الثالث ولا في الرابع فلم يلزمني اعتقاد الوجوب في الثاني لأن فعل المأمور به في الثالث غير متعين وجوبه وإنما يلزمني أن انظر في الأمر هل يفيد الوجوب إذا غلب على ظني أنني إن لم أنظر في ذلك فأعلم الوجوب وأفعل عقيبة فاتني الفعل فيلزمني حينئذ أن أنظر لأنني لا آمن كون الأمر على الوجوب فان قيل إن من لا يثبت العزم بدلا يوجبه ويقول إنه ليس ببدل فهذا لزمه النظر ليعلم وجوب المأمور به لأنه إن كان المأمور به واجبا لزمه أن يفعله أو يعزم على أدائه قيل إن كثيرا منهم لا يقول بوجوب العزم ومن يقول منهم بوجوبه يقول إنما يجب إذا علم المكلف وجوب الفعل وقبل أن يعلم ذلك لا يلزمه العزم وأما من أثبت العزم بدلا فانه يقول يلزم هذا المكلف في الثاني أن
ينظر في الأمر هل يقتضي الوجوب لأنه يلزمه معجلا أن يفعل إما المامور به أو العزم على أدائه وإنما يلزمه العزم إذا كان المعزوم عليه واجبا فلا يأمن المكلف أن يكون الأمر على الوجوب وإن لم ينظر في ذلك معجلا فاته أحد الواجبين وأما إن كان لا يعلم أن ألفاظ الإيجاب المطلقة ليست على الفور ولم يعلم أن الأمر على الوجوب فان له أن يقدم النظر في أن الأمر لو كان على الوجوب لما اقتضى الفور فاذا علم ذلك سقط عنه تقديم النظر في وجوب الفعل إلا على قول من يثبت العزم بدلا على ما بينا
ومنها أن يقال لو جاز تأخير المأمور به عن الوقت الثاني أدى إلى أقسام كلها باطلة وما أدى إلى الباطل باطل وبيان ذلك أنه لو جاز تاخيره عن الثاني لم يخل من أن يجوز تأخيره لا إلى غاية أو إلى غاية لا يجوز أن يؤخر عنها فإن جاز لا إلى غاية لم يخل من أن يجوز ذلك لا إلى بدل أو إلى بدل وهذا الثاني ينقسم إلى أن يكون البدل هو العزم على ادائه في المستقبل أو الوصية كالحج وإن جاز تأخيره إلى غاية لم تخل تلك الغاية إما أن تكون موصوفة أو معينة أما المعينة فيجوز أن يقال له أخره إلى الوقت العاشر أو اليوم الفلاني ولا تؤخره عنه وأما الموصوفة فنحو أن يقال إذا غلب على ظنه أنه إن لم يشرع في أداء المأمور به فاته وهذا ضربان أحدهما أن يغلب على ظنه ذلك بأمارة أو لا بأمارة والأمارة نحو المرض وعلو السن وكل هذه الأقسام باطلة
أما القول بجواز تأخير المأمور به لا إلى غاية من غير بدل فانه ينقض وجوبه ويلحقه بالنوافل وأما القول بأنه يجوز تأخيره إلى بدل هو الوصية فباطل أيضا لأن ذلك ليس بعام في كل العبادات لأنه ليس كل العبادات تثبت بالوصية وعلى أنه إن جاز أن يكون أمر الله سبحانه لنا أن نفعل العبادة لا يمنع من أن نعزم على الإخلال بها ونوصي غيرنا بها لم يمنع أمرنا للوصي من أن يوصي بما وصينا به وكذلك القول في الوصي الثاني والثالث الى غير غاية
وأما كون العزم بدلا فقد أفسدنا بدلا لا دليل على كونه بدلا وليس يجوز إثبات بدل لا دليل عليه وإذا لم يجز كونه بدلا لم يجز تاخير العبادة لأن تأخيرها موقوف على إثبات بدل لا دليل عليه وليس لأحد أن يقول قد أجمعت الأمة على وجوب العزم لأن قيام الدلالة على وجوب الشيء لا يقتضي كونه بدلا من غيره والجواب يقال لهم لم زعمتم أنه لا دليل يدل على كون العزم بدلا فان قالوا لأنه لا ذكر للعزم في الأمر قيل لهم ولا ذكر للوقت الثاني في الأمر ولستم بأن تنفوا كون العزم بدلا لأنه غير مذكور في الأمر وتتوصلون بذلك إلى تعيين الوقت الثاني بأولى من أن ننفي تعيين الوجوب بالوقت الثاني ونتوصل بذلك إلى اثبات بدل لأنه لا يمكن بعد ذلك إلا إثبات بدله وقد أفسد كون العزم بدلا فقيل إن العزم على أداء العبادة واجب لا على سبيل البدل عنها لأنه يجب على المكلف أن يعزم على أدائها قبل دخول وقتها مع علمنا بأن الوجوب لم يحصل قبل وقتها وأجيب عن ذلك بأنه لا يلزم العزم على فعلها قبل أن يجب وإنما يقبح كراهة فعلها فأما أن يعزم الإنسان ويريد فعلها فلا يجب ويمكن أن يعترض هذا الجواب فيقال له إنه إذا وجبت العبادة وجاز تأخيرها فليس يجب عليه إلا ما يجب عليه قبل دخول وقتها فان كان يجب عليه في أحدهما العزم وجب أيضا في الآخر وإن وجب عليه ألا يكره العبادة وجب عليه ذلك ها هنا وليس يمكن أن يدعي أن الأمة فصلت بين العزم على الأداء وبين نفي الكراهة فأوجبت أحدهما قبل الوجوب وأوجبت الآخر بعد توجه الوجوب ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن نسلم أن الواجب قبل دخول الوقت وتوجه الوجوب مثل ما يجب بعد توجه الوجوب إما عزم أو فقد كراهة ثم يقال إنه لا يمتنع أن لا يكون ذلك بدلا قبل توجه الوجوب ويكون بدلا وقائما مقام المبدل في المصلحة كلها أو بعضها بعد توجه الوجوب لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل أو الإخلال بالفعل في بعض الأوقات بدلا من شيء وفي وقت آخر لا يكون بدلا منه فلا يجوز أن يمنع من كون العزم بعد دخول الوقت بدلا من العبادة لأجل أنه يجب فعله قبل الوقت ولا يكون بدلا
طريقة أخرى في العزم لو كان العزم بدلا من العبادة لم يخل إما أن يجب في الوقت الثاني بدلا من العبادة أو يجوز تأخيره وتأخير العبادة عن الثاني فان جاز تأخيرهما كان القول في العزم كالقول في العبادة المأمور بها ولم يقف ذلك على غاية ولحقا جميعا بالنوافل وإن وجب العزم في الثاني إن لم يفعل المأمور به فيه لم يجز ذلك لأن بدل العبادة إنما يجب على حد وجوبها ليكون فعله جاريا مجرى فعلها ومعلوم أن الآمر عندهم إنما أوجب أن نفعل العبادة في وقت غير معين ولم يعين وجوبها في الثاني فينبغي أن يكون بدلها يجب في وقت غير معين وفي ذلك بطلان تعيينه بالثاني فان قالوا إن الأمر قد اقتضى وجوب الفعل في الثاني قيل لهم إن أردتم بذلك أنه عين وجوبها فيه ولم يرخص في تأخيرها عنه فذلك هو القول بالفور وذلك يمنع من تأخيرها ويغني عن البدل إلا أن يدل دلالة مبتدأة عليه وإن أردتم أن الأمر قد اقتضى كون الفعل في الثاني مرادا ومسقطا للفرض قيل لكم وقد اقتضى أن يكون في فعله في الثاني والثالث كذلك فقد صار موجبا له في وقت غير معين فيجب أن يكون بدله الساد مسده هذه حالة ويقال لهم إذا كان الأمر قد اقتضى أن فعل العبادة في الثاني كفعلها في الثالث والرابع فلم منعتم المكلف من تأخيرها عن الثاني إلا ببدل وهو يقول إني إنما أؤخرها لأن المصلحة تحصل لي في الثالث كما تحصل لي في الثاني فأن قالوا لأن الأمر اقتضى الوجوب في الثاني والثالث على وجه لا يمنع من التأخير ولا يتم ذلك إلا مع البدل فجرى مجرى أن يقول المكلف هذا الفعل واجب في الثاني ويجوز تأخيره إلى الثالث في أنه لا يجوز تأخيره إلا ببدل إلا انتقض وجوبه فيه قيل إن كان المكلف قد قال إنه واجب في الثاني لا يجوز تأخيره عنه ويجوز مع ذلك تأخيره الى الثالث فذلك متناقض وإن قال إنه واجب في الثاني والثالث على معنى أن الفرض يسقط بالفعل في كل واحد منهما فلو صرح بذلك لما احتجنا إلى بدل في الثاني
طريقة أخرى لو كان العزم في الثاني بدلا من أداء العبادة فيه لم تخل
العبادة من أن يتضيق أداؤها في وقت من الأوقات أو لا يتضيق فان لم يتضيق فحكم العبادة في كل الأوقات حكم الثاني فكما جاز للمكلف تأخيرها عن الثاني جاز له تأخيرها عن سائر الأوقات وإذا جاز له تركها في جميع الأوقات لم يجز أن يجب عليه العزم على أدائها لأنه لا يجوز أن يجب على الإنسان أن يعزم ويقصد أن يفعل ما يجوز له تركه لأن في ضمن قولنا يجب عليك أن تعزم على الفعل في الثاني إيجابا للفعل في الثاني فكون العزم بدلا من واجب يقتضي وجوبه وكونه عزما على ما يجوز تركه يقتضي جواز تركه فان قالوا إن المأمور به يتضيق أداؤه في بعض الأوقات وهو الوقت الذي يغلب على ظن المكلف أنه إن لم يفعله فيه فاته فعله قيل لهم فكأن المكلف خير في فعله وتركه قبل هذا الوقت وضيق وجوبه عليه فيه فجرى مجرى أن يقول المكلف صريحا للمكلف أنت مخير في فعل هذه العبادة إلى أن يغلب على ظنك أنها تفوت إن لم تؤدها فحينئذ يتضيق وجوبها ولو قال ذلك لما كان للمنع من تأخيرها قبل هذا الوقت لا إلى بدل وجه مع أن المكلف قد رخص في تأخيرها ولم يذكر بدلا لأن البدل إنما يجب بعد أن يكون المبدل قد تضيق وجوبه في نفسه فيستحيل أن يجوز تركه لا إلى بدل فان قالوا لو لم يثبت البدل انتقض وجوبها فيما قبل قيل إنه لا ينتقض الوجوب الذي هو بمعنى أن الفوض يسقط بالفعل لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل مصلحة في هذا الوقت وفيما قبله على سواء فيخير الله سبحانه بينهما ولا وجه لإيجاب البدل والحال هذه فان قالوا إنما ألزمناه العزم وجعلناه بدلا لأننا لا نأمن أن يموت من غير أن يغلب على ظنه أنه يموت فتفوته العبادة فألزمناه ما يقوم مقامها في الوقت الثاني والثالث قيل لهم إن المكلف إذا مات في زمان التخيير وقبل زمان التضييق ولم يفعل الفعل لم يكن عليه تبعة وإذا لم تكن عليه تبعة لم يلزمه البدل
طريقة أخرى في العزم لو كان العزم في الثاني بدلا من فعل العبادة فيه لم يخل إما أن يقوم مقام فعلها في ثبوت المصلحة فيه أو لا يقوم مقامها فيه فان
لم يقم مقامها فيه لم يكن بدلا منها ولم يجز العدول عنها إليه إذ في ذلك تفويت بعض المصلحة وإن قام مقامها فيه فقد استوفيت المصلحة بفعله فلا وجه لوجوب العبادة بعد ذلك وفي ذلك سقوط الفرض بالعزم فان قالوا إنه يقوم مقام العبادة في ذلك الوقت ويبقى فعلها واجبا في الأوقات الأخر قيل إن الأمر لم يفد وجوب العبادة في الأوقات على الجمع حتى إذا سقط الفرض في الوقت الثاني بقي ما بعده وإنما أوجب فعلا واحدا ولهذا لو فعله في الثاني لم يلزمه فعله فيما بعد ذلك الأمر فاذا فعل ما يجري مجرى فعله العبادة في الثاني وجب أن يسقط الفرض الثابت بذلك الأمر كما يسقط لو فعل العبادة المأمور بها وإنما يجوز أن يثبت مثله في الثالث والرابع بأمر آخر كما يجوز ذلك لو فعل نفس المأمور به فان قالوا ما تنكرون أن تكون العبادة لو فعلت في الثاني لكانت مصلحة في الثالث والرابع وسائر الأوقات إلى حال الموت فاذا فعل بدلها وهو العزم سد مسدها في حصول المصلحة في الثالث وتبقى المصلحة في الأوقات الأخر لا تحصل إلا بالمعزوم عليه أو بعزم يحصل في كل وقت فيقوم مقام المعزوم عليه في ثبوت المصلحة في الوقت الذي يليه قيل هذا يقتضي أن يكون المكلف إذا مات وهو موال للعزم فانه يكون قد استوفى مصلحة الحج وفي ذلك سقوط فرضه وفرض العزم لو عاش وقد أجمعت الأمة في كل من مات ولم يحج أنه لو بقي وهو صحيح موسر للزمه الحج فان قالوا إن الحج هو مصلحة في أفعال تقع في كل الأوقات إلى أبعد عمر يجوز أن يحيي فيه المكلف في العادة فاذا مات المكلف قبل ذلك ولم يحج وجب أن يقال لو عاش لزمه الحج لأنه لو عاش لكان الحج أو العزم على أدائه مصلحة في أفعال تحصل في تلك الأوقات فاما ما بعد أطول الأعمار بزمان طويل فلا يمكنكم أن تدعوا فيه إجماعا قيل هذا يقتضي أن الإنسان لو حج عند بلوغه فانه يكون ذلك مصلحة في فعل يقع منه بعد مائة سنة وأكثر وهذا يبعد لأن اللطف إذا تراخى صار في حكم المنسي
فأما القول بأن العبادة تتضيق في وقت معين فلم يقل به أحد ولا دليل يدل
عليه وليس بعض الأوقات المعينة بذلك أولى من وقت فالقول بأنها تتضيق عند ما يغلب على الظن أنها تفوت إن لم تفعل ولا يحصل ذلك الظن عن أمارة لا يصح لأنه لا ينفصل من ظن السوداوي والقول بأنها تتضيق عند ظن يحصل على أمارة كمرض وعلو سن باطل لأن كثيرا من الناس يموت فجأة وذلك يقتضي أنه ما كان يجب عليهم أن يفعلوا العبادة لا محالة مع أن ظاهر الأمر اقتضى أن يفعلوها لا محالة لأن صيغة افعل تقتضي أن يفعل المقول له لا محالة والجواب أن قول القائل لغيره افعل وإن اقتضى أن يفعل لا محالة فانه يقتضي أن يفعل لا محالة في غير وقت معين لأنه يقتضي أنه متى فعل فقد قضي عهدة الأمر فصار مفيدا لأن يفعل لا محالة في غير وقت معين وذلك يقتضي أن يخيره في الأوقات ولا يدخل في كونه واجبا إلا بأن يضيقه في بعض الأوقات ولا وقت يمكن ذلك فيه إلا إذا خشي الفوات إن أخره عنه وذلك يقتضي أن من لم يغلب على ظنه أن الفعل يفوته إن لم يفعله في الوقت الذي قه انتهى إليه لم يجب عليه أن يفعل لا محالة
باب القول في الامر إذا كان مؤقتا بوقت محدود بأول وآخر
اعلم أن الوقت المضروب للفعل إما أن يتسع للفعل أو لا يتسع له فان لم يتسع له لم يجب أن يكلف الإنسان إيقاع الفعل فيه لأنه تكليف لما يطاق ويجوز أن يكون وجود ذلك الوقت على بعض الوجوه سببا لوجوب القضاء نحو أن تطهر الحائض أو يبلغ الغلام وقد بقي من الصلاة مقدار ركعة ونحو أن يحرم الإنسان بحجتين لأن ذلك سببا لقضاء إحداهما عند أصحابنا ونحو أن ينذر الإنسان أن يصوم في يوم يقدم فيه فلان فيقدم وقد مضى من النهار بعضهوأما إن اتسع الوقت للفعل فذلك ضربان أحدهما ألا يزيد الوقت على
مقدار الفعل نحو صوم يوم ولا إشكال في أن جميعه وقت للوجوب والآخر أن يزيد الوقت على مقدار الفعل كوقت صلاة الظهر
وقد اختلف الناس في وقت الوجوب من ذلك فقال محمد بن شجاع الثلجي وأصحاب الشافعي وشيخانا أبو علي وأبو هاشم وأصحابهما إن أول الوقت ووسطه وآخره وما بين ذلك من حالاته وقت للوجوب واختلف هؤلاء فمنهم من لم يثبت للصلاة في أول الوقت ووسطه بدلا فيه ومنهم من أثبت للصلاة في كل وقت من هذين الوقتين بدلا واختلفوا فقال أبو علي وأبو هاشم إن بدل الصلاة في أول الوقت ووسطه هو العزم على أدائها في المستقبل وقال بعض أصحابنا إن لها في أول الوقت ووسطه بدلا يفعله الله سبحانه وقال قوم إن أول الوقت هو وقت الوجوب وإنما ضرب آخره للقضاء وقال أكثر اصحابنا إن آخر الوقت هو وقت الوجوب واختلفوا في إيقاع الفعل فيما قبل ذلك فقال بعضهم هو نفل يسقط به الفرض وحكي عن الشيخ ابي الحسن أن الفعل يقع في أول الوقت مراعى فإن أدرك المصلي آخر الوقت وليس هو على صفة المكلفين كان ما فعله نفلا وإن أدركه على صفة المكلفين كان ما فعله واجبا وحكي عنه الشيخ أبو عبد الله أنه قال إن أدرك المصلي آخر الوقت وهو على صفة المكلفين كان ما فعله مسقطا المفرض وهذا أشبه من الحكاية الأولى وحكي أبو بكر الرازي عن أبي الحسن أن الصلاة يتعين وجوبها بأحد شيئين إما بأن تفعل وإما بأن يضيق وقتها ويمكن أن يفسر أكثر هذه الأقاويل تفسيرا صحيحا لا يقع فيه نزاع ويمكن أن يفسر تفسيرا يقع فيه النزاع على ما نبينه عند الكلام فيها وينبغي أن نبين معنى قولنا إن الصلاة واجبة في أول الوقت ووسطه وآخره ثم نبين جواز كونها واجبا فيها ثم نبين ورود التعبد به
أما معنى قولنا إن الصلاة واجبة في جميع الوقت فهو أنه إذا فعلها في أوله كانت كما لو فعلها في وسطه وآخره في سقوط الفرض وحصول المصلحة المقتضية للوجوب
فأما جواز ورود التعبد بذلك فهو أنه لا يمتنع في العقل أن تكون الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره تتساوى في كونها لطفا داعيا إلى طاعة واجبة بعد خروج الوقت وداعيا إلى طاعة مندوب إليها قبل خروج الوقت ولا يمتنع أن يكون داعيا إلى طاعة واجبة بعد خروج الوقت فقط ولا يكون فعلها بعد خروج الوقت مصلحة فيما كانت مصلحة فيه قبل خروج الوقت لكن إذا فرط المكلف في فعلها لزمه قضاؤها لأن قضاءها يكون مصلحة في دون ما كان الأداء مصلحة فيه فاذا كان كذلك لم يجز أن يضيق الله سبحانه فعلها في أول الوقت مع أن الغرض بايجابها وهو المصلحة يحصل بفعلها في آخر الوقت ولا يجوز أن لا يضيق الله سبحانه فعلها في آخره مع أن المصلحة لا تحصل إذا أخرت عنه ولا يمتنع أيضا أن تكون الصلاة في كل وقت قبل آخر الوقت مصلحة في طاعة تليها وفي طاعة بعد خروج الوقت فإن لم يفعلها فيه فعل الله سبحانه ما يقوم مقامها في الطاعة التي تليها وبقي على المكلف فرضها لما يدعو إليه من الطاعة بعد خروج الوقت ولا يمتنع أيضا أن يكون العزم في كل وقت على أدائها في الثاني أو في غيره من أفعال المكلف يقوم مقامها في المصلحة التي تليها دون المصلحة التي تدعو إليها بعد خروج الوقت وإذا لم تمتنع كل هذه الوجوه لم يمتنع ورود التعبد عليها والذي نذهب إليه أن الصلاة في أول الوقت ووسطه مصلحة في طاعة واجبة بعد خروج الوقت وفي طاعة مندوب إليها قبل خروج الوقت إذا كان المعلوم من حال المكلف انه لا يدرك ما بعد الوقت وهو حي
فاما الكلام في ورود التعبد بذلك فيقع في وجوه منها الكلام على من خص الوجوب بأول الوقت ومنها الكلام على من خصه بآخره ومنها الكلام على من جعل الفعل في أول الوقت مراعي ومنها الكلام على من عين الوجوب بأحد شيئين ثم يقع الكلام بعد ذلك في إثبات البدل هل هو من فعل الله سبحانه أو من فعلنا
أما الكلام على من خص الوجوب بأوله فهو أن يقال له أتزعم أن تأخير الصلاة عن أول الوقت لا يجوز كما لا يجوز تأخيرها عن آخره ويستحق الذم على أحدهما كما يستحق على الآخر فان قال نعم دفع قوله الإجماع وإن قال لا قيل له فقد نقضت قولك باختصاص الوجوب بأول الوقت ويقال له لماذا ضرب الوقت فان قال ليكون ما يفعل بعد أول الوقت قضاء قيل له الأمة مجمعة على أنه ليس بقضاء ولا يجوز أن تؤدي الصلاة بعد أول الوقت بنية القضاء وأيضا فلا فائدة لضرب الوقت في ذلك لأن ما يفعل بعده يكو قضاء أيضا وايضا فالوجوب مستفاد من الأمر وهو متعلق بأول الوقت وآخره ووسطه فيجب أن يفيد الوجوب في الكل ويتضيق بآخره لأنه جعل غاية وقت الوجوب
فأما من خص الوجوب بآخره فانا نفرض عليه ما يعنيه بقولنا إن الوجوب شائع في جميع الوقت فان أقر به وإلا دللنا عليه فنقول إنا نعني بذلك أن الصلاة في أول الوقت كهي في وسطه وآخره في حصول المصلحة بها المقتضية للوجوب وفي سقوط الفرض فان أجاب إلى ذلك فقد وافق في المعنى وإن منع عن ذلك قيل له إن لم تكن الصلاة قائمة مقام فعلها في آخره في حصول المصلحة وجب أحد أمرين إما أن تكون المصلحة باقية فيلزم فعل الصلاة في آخر الوقت مع أنها مفعولة في أوله وإما أن تكون المصلحة قد فاتت فان كانت قد فاتت فقد صارت الصلاة في اول الوقت مفسدة وفي ذلك قبحها والإجماع يمنع من قبحها ويقتضي الإجماع ايضا أن فعل بعض الصلوات في أول وقتها افضل يبين كونها مفسدة أنه إذا كان المكلف لو صلى في آخر الوقت حصلت له المصلحة واللطف وإذا صلى في أوله ولم تحصل له تلك المصلحة وخرجت الصلاة في آخر الوقت من أن تكون مصلحة وحصلت المعصية التي كانت الصلاة في آخر الوقت لطفا في الإخلال بها فقد حصلت الصلاة في أول الوقت داعية إلى هذه المعصية ومفوتا لما يدعو إلى الطاعة فان قيل أليس تقديم الزكاة على الحول يسقط الفرض وليس بمفسدة قيل إنما
يسقط الفرض لأنه يقوم مقامه في المصلحة ولهذا لم يطلق أحد من الأمة القول بانه صدقة تطوع ونافلة مع أنها مسقطة للفرض فان قيل وإذا كانت قائمة مقام الزكاة بعد الحول في المصلحة فما معنى تعليق الوجوب بحؤول الحول قيل الفائدة في ذلك أن يكون للإمام إلزام رب المال الزكاة بعد حؤول الحول ولا يكون له إلزامه اخراج الزكاة قبله لأن الوجوب موسع عليه ويدل على شمول الوجوب لأوقات الصلوات أن الوجوب مستفاد من الأمر والأمر نتعلق بأول الوقت وآخره وما بينهما فشمل الوجوب هذه الأوقات
وقد استدل في المسألة بأشياء
منها أنه لو كانت الصلاة نافلة في أول الوقت لصح إيقاعها بنية النفل لمطابقتها لما عليه الصلاة في نفسها وقد اعترض ذلك بأنه يجوز إيقاعها بنية كونها ظهرا نفلا وأجيب عن ذلك بأن كونها ظهرا نفلا يتناقض وهذا إنما يتناقض إذا ثبت أن صلاة الظهر لا تكون إلا واجبة وفيه النزاع وقد أجيب عن الدليل فقيل أليس تقديم الزكاة يكون نفلا ولا يجوز إيقاعها بنية النفل فان قلتم يجوز إيقاعها بنية كونها زكاة نفلا قيل يجوز إيقاع صلاة الظهر في أول الوقت بنية كونها ظهرا نفلا وليست الشناعة في ذلك إلا كالشناعة في كون الزكاة نفلا ويمكن أيضا أن يجاب عن الدليل فيقال إن أردتم بنية النفل أن ينوي أن يفعل ما يجوز تركه في أول الوقت لا إلى بدل فيه فهو قولنا وإن أردتم أن ينوي أن يفعل ما يجوز تركه وترك أمثاله في كل الأوقات مع السلامة فليس هذا قولنا فلم يلزمنا حوار أن ينويه
ومنها قولهم إن الصلاة في أول الوقت يراعي فيها أذان وإقامة وعدد مخصوص وليس هذا حال النوافل وللمخالف أن يقول إن النوافل التي تسقط الفرض وتفعل في الوقت المضروب هذه سبيلها
ومنها أنه كان يجب أن يكون من لم يؤد الصلاة إلا في وقتها الأول غير مؤد للفرض من الصلوات ولا قائما بالواجب منها وللمخالف أن يقول إن
إطلاق ذلك يوهم أن الصلاة وجبت عليه فلم يقم بها وليس الأمر كذلك ولهذا لا يقال فيمن يقدم زكاته في كل عام إنه لم يقم بالواجب من الزكاة لأن ذلك صفة ذم والذم لا يلحق من قدم الواجب قبل وقت وجوبه إذا أذن في ذلك
ومنها قولهم إن تقديم صلاة المغرب أفضل من تأخيرها والنفل لا يكون أفضل من الواجب وللمخالف أن يقول بل يجوز أن يكون أفضل منه إذا كان متقدما على الواجب ومسقطا له ولهذا يقال إن تقديم الزكاة على الحول مع شدة حاجة الفقراء أفضل من تأخيرها إلى حؤول الحول
واحتج القائلون إن الصلاة نافلة في أول الوقت بأن الواجب في الوقت هو ما لا يجوز تأخيره عن الوقت إلا إلى بدل فيه والصلاة في أول الوقت يجوز تأخيرها عنه لا إلى بدل فيه لأنه لا دليل عليه ولم تكن واجبة فيه وإذا لم تكن واجبة فيه وكانت مأمورا بها ثبت كونها نفلا فيه وقالوا وليس لكم أن تقولوا إنها تفارق النافلة وتدخل في جملة الواجبات من حيث لم يجز تركها أصلا لأنا إنما استدللنا على كونها نافلة في الأول من حيث جاز تأخيرها عنه ولم نستدل على أن أمثالها نافلة في كل الأوقات والجواب أن وصفنا للفعل بأنه واجب في الوقت يستعمل على وجهين أحدهما أنه لا يجوز الإخلال به في ذلك الوقت إلا إلى بدل فيه وهذا لا نعينه في الصلاة في الوقت الأول والآخر أنه يقوم مقام غيره من الواجبات المضيقة في وجه الوجوب وهذا هو الذي نعنيه بقولنا إن الصلاة واجبة في أول الوقت وقد بينا أنه لا بد للمخالف من أن يقوله فما يلزمنا عليه فهو لازم له ايضا وليس يلزمنا على هذا القول أن لا نجيز تأخير الصلاة عن أول الوقت لا إلى بدل لأنه إذا كانت الصلاة في الوقت الثاني تسد مسد وقوعها في الوقت الأول في الفرض والمصلحة لم يجز أن يلزم في الوقت بدلها هو إذا تركها فيه صار إلى ما يجري مجراها فاذا كان كذلك فأي فائدة في إلزام البدل
فأما القول بأن الفرض يتعين بإيقاع الفعل فان أريد بذلك أنه إذا فعل الفعل يجب أن يفعل مرة ثانية وجوبا معينا مضيقا فباطل لأن فعل المفعول غير ممكن فايجابه قبيح وإن أريد أنه يلزم بالشروع فيه إتمامه فهذه حالة النوافل عند أصحابنا وقد تكلمنا على من قال إن الفعل نافلة في أول الوقت وإن أريد أنه إذا فعل الفعل علمنا أنه قد تعين سقوط الفرض به وأنه لا فرض بعده في ذلك الوقت إلى آخره فذلك صحيح وقد كنا نحكم قبل الفعل أيضا بأنه إن وجد فهذه سبيله
فأما القول بأن المكلف إذا صلى في أول الوقت وأدرك آخره على صفة المكلفين كان ما يفعله واجبا فان أريد به أنه يبين لنا أنه قد كان ألزم الفعل في الأول ومنع من تأخيره عنه فذلك يؤدي إلى أنه حظر عليه في الأول التاخير ولم يعرف في ذلك الوقت أنه قد منع من التأخير وذلك تكليف ما لا يطاق وإن أريد به أنه يبين لنا أن ذلك الفعل قد أسقط عن المكلف أن يفعل في آخر الوقت مثله وأنه قائم مقام الفعل في آخر الوقت في المصلحة التي تحصل بعده فصحيح وإن أراد الشيخ أبو الحسن بقوله إن المكلف إذا لم يدرك آخر الوقت على صفة المكلفين كان ما فعله في أول الوقت نافلة أنه يبين لنا في آخر الوقت أنه ما كان قد ألزم المكلف الفعل في أوله فليس بصحيح لأنه يجب أن يعرف ذلك قبل أول الوقت وإن أراد أنه يبين لنا أن ما فعله لم يكن لطفا في واجب وأنه لطف في نافلة فصحيح وهو الذي ينصره لأنه لو كان لطفا في واجب يوقعه قبل حال موته لكان الله سبحانه قد ضيق عليه الوجوب في أول الوقت والدلالة على أن الصلاة في أول الوقت مصلحة في طاعة نافلة قبل خروج الوقت إذا كان المصلي يموت قبل خروج الوقت فهي أنها لو لم تكن كذلك لما حسن تكليفها لمن المعلوم أنه يموت قبل خروج الوقت لأن وجه وجوبها غير حاصل فيه وهو كونها داعية إلى طاعة واجبة بعد الوقت إذ المكلف ليس يدرك هذا الوقت حيا وفي إجماع الأمة على أن من مات قبل
خروج الوقت لا يكون ما فعله من الصلاة في أول الوقت مباحا بل طاعة مأمور بها دليل على ما قلناه لأنها لا تكون طاعة إلا وهي مصلحة في طاعة قبل موته وليس يجوز أن تكون تلك الطاعة واجبه لأنها لو كانت واجبة لضيق الله سبحانه وجوب الصلاة عليه فثبت أنها مصلحة في طاعة مندوب إليها فان قالوا فيجب أن تكون صلاة هذا المكلف نافلة قيل إن أردتم بكونها نافلة ما ذكرتم وأنه لو لم يفعلها حتى مات لم يستحق الذم فصحيح وهو الذي نصرناه وإن أردتم أنه لو بقي المصلي إلى بعد الوقت لم تكن صلاته لطفا في واجب فلا
فأما القول بأن العزم بدل من الصلاة في الوقت الأول فانه إن جعل هذا القائل العزم جاريا مجرى الصلاة في أول الوقت من كل وجه لزم أن يكون ما فعله مسقطا لفرض الصلاة كما أن الصلاة في أول الوقت مسقطة للفرض إذ قد سد العزم مسد فعل الصلاة وإن أريد أن العزم يقوم مقام فعلها من وجه دون وجه نحو أن تكون الصلاة مصلحة في طاعة تليها وفي طاعة بعد خروج الوقت فيقوم العزم مقام فعلها في أول الوقت في حصول المصلحة التي تليها وتبقى المصلحة الأخرى بكون الصلاة في الوقت الثاني مصلحة فيها ومصلحة في الوقت الثالث هكذا في كل الأوقات إلى أن يتضيق الوقت فلا يكون العزم قائما مقام الصلاة في المصلحة التي تكون بعد الوقت والذي يبطله هو أنهم إذا توصلوا إلى إثبات البدل فيجب أن يثبتوه على حد ثبوت المبدل ومعلوم أن ظاهر الأمر اقتضى إيجاب الفعل في الأوقات من زوال الشمس إلى آخر الوقت على البدل فكان الواجب أن يفعل المكلف الصلاة في وقت من هذه الأوقات أي وقت شاء هكذا ظاهر الأمر فيجب أن يكون بدل ذلك يلزم فعله في وقت غير معين من هذه الأوقات ولا يتعين في الأول كما لم يتعين المبدل ويجب إذا فعل البدل في وقت من هذه الأوقات أن يسقط الفرض كالمبدل وأيضا فلو لزم المكلف ان يفعل الصلاة في أول الوقت أو العزم لكان قد أخذ عليه أن يتحفظ من السهو وأن يجب علينا أن نوقظه من نومه في
هذا الوقت لأنه قد أخذ عليه في هذا الوقت فعل يمنع منه النوم كما يلزم أن نوقظه عن نومه في آخر الوقت وأيضا فان الأمر اقتضى إيجاب الصلاة علينا في الأوقات كلها على البدل ولا دليل يدل على إثبات بدل للصلاة لأنا قد بينا حسن تكليفها من غير بدل ولا يجوز إثبات ما لا دليل عليه وبأكثر هذه الوجه يبطل قول من قال إن بدل الصلاة هو فعل يفعله الله سبحانه يقوم مقام الصلاة كونها مصلحة في طاعة تختص بالوقت الثاني على ما ذكرناه في العزم وتختص ذلك بوجه آخر وهو أنه كان يجب أن لا يحسن تكليف الصلاة من يعلم الله أنه يخترم في الوقت لأنه يقوم فعل الله سبحانه مقام فعله في المصلحة الحاصلة قبل خروج الوقت فلو كلفه الله تعالى الصلاة لكان إنما كلفه لمجرد الثواب فقط
وقد استدل أصحاب العزم على إثبات البدل فقالوا الصلاة واجبة في أول الوقت فلا يجوز كونها واجبة فيه مع جواز تأخيرها عنه إلا إلى بدل ولا بدل إلا العزم والجواب يقال لهم أتعنون بوجوبها في الأول أنه محظور تأخيرها عنه فان قالوا نعم قيل لهم من سلم لكم ذلك أو ليس الأمر دل على إيقاعها في الأول والثاني والثالث على البدل فكيف حظر تأخيرها حتى يطلب لجوازه فعل بدل وعلى أن حظر تأخيرها مع إباحة تأخيرها متناقض ولم يصح ثبوته حتى يتبعه إثبات بدل فان قالوا نعني بوجوبها في الأول أنها على صفة المصلحة الحاصلة بالصلاة في آخر الوقت قيل لهم ولم إذا كان كذلك لا يجوز تأخيرها إلا إلى بدل مع أنه يؤخرها إلى ما يساويها في وجه الوجوب ثم يقال لهم ولم زعمتم أنه لا بدل إلا العزم فان قالوا لإجماع الأمة على وجوبه على من أخر الصلاة عن الأول قيل إجماع الأمة على ذلك كإجماعها على وجوبه قبل دخول الوقت وليس يظهر أن الأمة فصلت بين الأمرين فأوجبت بعد دخول الوقت فعل العزم ولم توجبه قبل الوقت وإنما حضرت قبل الوقت كراهة فعل الصلاة وقد تقدم ذلك في الباب الأول فما يؤمنهم أن يكون البدل هو الإخلال بالكراهة ويكون ذلك سادا في هذا الوقت مسد الصلاة في
المصلحة ويمكن أن يستدلوا على إثبات بدل فيقولوا إن الصلاة لطف في واجب بعد خروج الوقت ولطف في واجب قبل خروج الوقت أما كونها لطفا بعد خروج الوقت فالدلالة عليه أنه قد أتيح له تأخيرها إلى آخر الوقت فلو لم يكن إلا لطفا في طاعة في الوقت لما أتيح تأخيرها عن وقت تلك الطاعة فأما الدلالة على أنها لطف في واجب في الوقت ايضا فهي أنها لو لم تكن لطفا إلا في واجب بعد الوقت لما حسن تكليفها من المعلوم أنه يموت قبل خروج الوقت وإذا كانت لطفا في واجب قبل خروج الوقت لم يجز تأخيرها عن ذلك الوقت إلا إلى بدل ولا بدل إلا العزم لأن الأمة أجمعت على وجوبه دون وجوب غيره والجواب أنه يكفي في حسن تكليف الصلاة من المعلوم أنه يكون قبل خروج الوقت أن يكون فيها لطفا في طاعة مندوب إليها بفعل عقيب فعل الصلاة أو أن يكون كل جزء من الصلاة لطفا في مندوب وإذا جاز ذلك لم يجب أن يكون لها بدل من حيث هي لطف في ندب فان قيل فلم كان قولكم أولى من قولنا مع جواز ورود التعبد عليهما جميعا قيل أنتم الذي يلزمكم الترجيح لأنكم المستدلون وأيضا فان قولنا أولى من قولكم لأن التعبد بالصلاة في الوقت كله ورد مطلقا من غير بدل وإنما يثبت البدل للضرورة فاذا بينا إمكان قولنا وحسن ورود التعبد به لم يكن إلى البدل ضرورة فان قيل فيجب على ما قلتم أن يكون تقديم الصلاة في أول أوقاتها أولى لأنها تكون مصلحة في مندوب إليه وفي واجب والصلاة في آخر الوقت لا تكون مصلحة إلا في واجب فقط والجواب أنه لا يمتنع أن تكون الصلاة التي يستحب تأخيرها إذا فعلت في أول الوقت كانت لطفا في مندوب إليه يليها وفي طاعة واجبة بعد خروج الوقت وإذا فعلت في آخر الوقت كانت لطفا في طاعة واجبة وفي طاعات مندوب إليها بعد خروج الوقت ايضا أكثر مما تكون الصلاة في أول الوقت لطفا فيه من الطاعات المندوب إليها فلذلك كان تأخير الصلاة أفضل
باب في الامر المؤقت هل يقتضي الفعل فيما بعد الوقت إذا عصى المكلف في
الوقت أم لااعلم أنه لا يقتضي الفعل فيما بعد الوقت أطاع المكلف في الوقت أم عصى فيه ويحتاج فعله فيما بعد الوقت إلى دلالة أخرى لأن قول القائل لغيره افعل هذا الفعل في يوم الجمعة لا يتناول ما عدا الجمعة وما لم يتناوله الأمر لا يدل فيه على إثبات ولا نفي ولهذا لم يدل الأمر على استدعاء الفعل قبل الوقت ولو كان الأمر مقيدا بصفة لم يدل على وجوب ما لم يختص بها لما لم يتناول ما عدا تلك الصفة ولذلك لو قال الإنسان لغيره اضرب من كان في الدار لم يتناول من لم يكن فيها ولو أمرنا الله سبحانه أن نتصدق بأيماننا ثم تعذر ذلك علينا لما علمنا بذلك الأمر وجوب الصدقة باليسرى لكن علمنا أن الصدقة باليمنى الغرض منها إيصال النفع إلى الفقير فقط فانا نعلم وجوب الصدقة باليسرى لهذا الاعتبار والوقت وإن لم يكن في مقدورنا ولا هو وجه يوقع الفعل عليه فانه لا يمتنع أن يكون الفعل فيه مصلحة دون غيره ولهذا كانت الصلوات واجبة في أوقات مخصوصة وكان الصوم واجبا في شهر مخصوص ودفع الضرر عن النفس واجب في الوقت الذي يختص فيه الضرر دون غيره وإذا صح ما ذكرناه لم يجز ورود النسخ على الأمر المفيد للفعل الواحد المؤقت وإنما يرد على الأمر المفيد ظاهره أفعالا كثيرة فيدلنا النسخ على أنه ما أريد بعض تلك المرات فان قيل فاذادل الدليل على أن من عصى في الوقت يلزمه مثله أكان يكون ذلك قضاء قيل نعم إذا اختص بشروط القضاء وهي أشياء
منها أن يكون مثل المقضي ولهذا لم تكن الصلاة قضاء للصوم
ومنها أن يكون المقضي متعبد به في وقت مخصوص إما على الوجوب أو
على الندب ولهذا لو لم نتعبد بالفعل ثم أمرنا بمثله لم يكن قضاء
ومنها أن يكون سبب القضاء غير سبب المقضي ولهذا لو لم يقض الإنسان يوما فات من شهر رمضان ثم قضاه بعد ذلك لم يكن ذلك قضاء للقضاء لأن سببهما غير مختلف
ومنها أن يرد التعبد بالقضاء لأنه لو لم يتعبد به لم يسهم إذا فعل قضاء والله أعلم
باب في الامر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره في أول أوقات الإمكان هل
يقتضي فعله فيما بعد أم يحتاج إلى دليلأما القائلون بنفي الفور فانهم يقولون إن الأمر يقتضي الفعل فيما بعد ولا يحتاج المكلف إلى دليل وأما القائلون بالفور فيختلفون فمنهم من قال إنه يقتضي الفعل فيما بعد ومنهم من قال لا يقتضيه بل يحتاج المكلف إلى دليل وهو مذهب أبي عبد الله وحكاه عن الشيخ أبي الحسن ولم يفصل المؤقت من غيره ويقول قاضي القضاة بذلك لو ثبت القول بالفور
واحتج الأولون بأن قالوا قول القائل لغيره افعل معناه افعل في الثاني فان عصيت ففي الثالث فان عصيت ففي الرابع هكذا ابدا فان قال قائل ولم زعموا أن الأمر يتنزل هذه المنزلة قيل لأن ظاهر قوله افعل لا يتخصص بالوقت الثاني دون الثالث والرابع وإنما قالوا إنه يجب فعله في الثاني لأنه لو مل يجب فيه انتقض الوجوب المستفاد بالأمر فاجتمع في الأمر شيئان أحدهما الوجوب المقتضي للفور والثاني نفي تخصيص الأمر بالأوقات المقتضي لشياع الفعل في الأوقات فوجب الفور مع نفي تخصيص الأمر بالأوقات وشياع الفعل فيها ولا يمكن ذلك إلا إذا عصى المكلف في الوقت
الأول فصح أن مطلق الأمر من حيث اجتمع فيه ما يدل على ما ذكرناه يجري مجرى قول القائل افعل في الأول فان عصيت فافعل في الثاني فان قالوا الأمر وإن لم يختص بوقت معين فان الوجوب المستفاد من الأمر لما دل على الفور جعل الأمر مختصا بالوقت الأول قيل لهم إنما جعله مختصا بالأول ما لم تقع المعصية فاذا وقع بقي مطلق الأمر فان قالوا قد ثبت أن مطلق الأمر يقتضي وجوب الفعل في الثاني فجرى مجرى أن يكون الأمر مقيدا بالثاني قيل الفرق بينهما أنه إذا كان مقيدا بالثاني لم يكن غير مختص بالأوقات بل يكون مختصا بالوقت الثاني فلا يتنزل منزلة قول القائل افعل في الثاني فان عصيت فافعل في الثالث لأنه يتناول فعلا واحدا وليس كذلك إذا كان الأمر مطلقا
واحتج أبو عبد الله فقال قد ثبت أن مطلق الأمر يفيد إيقاع الفعل في الثاني فلم يتناول إيقاعه في الثالث لأنه يتناول فعلا واحدا والفعل المختص بالثاني غير المختص بالثالث لأن أفعال العباد لا يجوز عليها التقديم والتأخير والجواب أنه إن ثبت أن أفعال العباد هذه سبيلها فان الأمر لم يتناول تلك الأعيان وإنما يتناول ما له صورة يميزها المكلف فاذا أمرنا الله سبحانه بالحج فانما أمرنا بأفعال لها صفة مخصوصة سواء كانت واقعة في هذا الوقت أو في هذا الوقت واذا كان كذلك وكان الأمر لا يتخصص بالأوقات علمنا أنه يتناول ما اختص بتلك الصورة من الأفعال المختصة بتلك الأوقات فاذا بان أن الوجوب يفيد التعجيل بان أنه قد اختص بالأمر ما يقتضي التعجيل وما يقتضي التأخير ولا يمكن الجمع بينهما إلا على شرط المعصية
باب في الآمر هل يدخل تحت الأمر ام لا
اعلم أن هذا الباب يتضمن مسائلمنها أن يقال هل يمكن أن يامر الإنسان نفسه في المعنى أم لا وليس في
إمكان ذلك شبهة لأنه يمكن الإنسان أن يقول لنفسه افعل ويريد منها الفعل
ومنها أن يقال هل يكون هذا القول مسمى بأنه أمر على الحقيقة أم لا والجواب أنه لا يكون أمرا على الحقيقة لأن من شرط كونه أمرا الرتبة وما يجري مجراها وذلك لا يتأتى إلا بين ذاتي لتكون إحداهما مستعلية ومرتبة على الأخرى
ومنها أن يقال هل يحسن أن يأمر الإنسان نفسه أم لا والجواب أنه لا يحسن ذلك لأن الفائدة بالأمر أن يكون دليلا على حال المأمور به أو يؤكد الدلالة أو يدل على إرادة فاعله الفعل ويكون ممن يتقرب إليه بالمصير إلى إرادته فيدعو علم المأمور بإرادته إلى أن يوقع مرادها وهذه الأمور منتفية في أمر الإنسان نفسه لأن الانسان يعلم إرادته وكون المأمور به طاعة قبل أمره من غير أن يراد علما من جهة الآمر إذ كان إنما يأمر لتقدم علمه بما له في الفعل المأمور به من الغرض
ومنها أن يقال هل إذا خاطب الإنسان غيره بالأمر يكون داخلا في جملة المأمورين وهذه المسألة وإن دخلت في مسائل العموم فذكرها ها هنا يجوز لتعلقها بهذه المسائل والجواب أنه إن كان المخاطب نالا للأمر من غيره نظر في خطابه فان كان يتناوله دخل فيهم والا لم يدخل فيهم مثال الأول أن يقول الإنسان لجماعة إن فلانا يأمرنا بكذا وكذا ومثال الثاني أن يقول إن فلانا يأمركم بكذا وكذا وإن نقل كلامهم غيره ولم يذكر عن نفسه شيئا نحو قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان هذا يتناول الكل لأن الخطاب من الله سبحانه يرد إلى كل
مكلف وإلا من استثناه الدليل وإن كان المخاطب بالأمر هو الآمر فانه لا يدخل تحت الأمر لما بيناه أنه لا فائدة فيه وذلك نحو أن يقول افعلوا كذا وكذا فان قيل فهل يدخل المخبر تحت الخبر قيل إن أردت أنه يدخل في أن يكون مخبرا لنفسه فلا لأنه لا فائدة في أن يخبر نفسه إذ ليس يخفى عليه حال المخبر عنه فيستدل عليه بخبره وإن أردت أنه يدخل في أنه يكون مخبرا عن نفسه فذلك جائزلأن الإنسان له غرض في أن يخبر عن حال نفسه كما أن له غرضا في أن يخبر عن غيره
باب في كيفية إيجاب الامر لفروض الكفايات
اعلم أن الأمر بالفعل إذا تناول جماعة على الجمع فذلك من فروض الأعيان والكلام في ذلك من باب العموم وقد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل بعض كصلاة الجمعة وقد لا يكون فعل بعضهم شرطا في فعل بعض وإذا تناول جماعتهم لا على الجمع فذلك من فروض الكفايات نحو أن يكون الغرض بتلك العبادة يحصل بفعل البعض كالجهاد الذي الغرض به حراسة المسلمين وإذلال العدو وقهره فمتى حصل ذلك بالبعض لم يلزم الباقين والفرض في ذلك موقوف على غالب الظن فان غلب على ظن الجماعة أن غيرها يقوم بذلك سقط عنها وحد الواجب لا يحصل في فعلها وإن غلب على ظنها أن غيرها لا يقوم به وجب عليها وحد الواجب حاصل في فعلها وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها لا يقوم به وجب على كل واحدة منها القيام به وكان حد الواجب قائما في فعل كل واحدة منها وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها يقوم به سقط الفرض عن كل واحدة منها وإن أدى إلى أن لا يقوم به أحد ولم يكن حد الواجب حاصلا في فعل كل واحدة منها فبان بما ذكرنا أن ما تقدم من حد الواجب ليس ينتقص بشيء من هذه الأقسام
باب في الامر الوارد بالشيء على شرط زوال المنع
ذهب شيوخنا رحمهم الله إلى أن الله عز و جل لم يعن بالأمر من يعلم أنه يمنع من الفعل وقال قوم إذا أمر الله قوما بالفعل وعلم أن فيهم من يمنع منه فانه قد عناه بالأمر بشرط زوال المنع ولم يختلفوا في جواز أمر الواحد منا غيره بالفعل بشرط قدرته على الفعل وانتفاء المنع منه وقال قاضي القضاة لم يختلفوا في أنه لا يجوز أن يفرد الله سبحانه المكلف الواحد بالأمر بالفعل وهو يعلم أنه يمنع منه قال ولم يختلفوا في أنه لا يجوز أن يأمر من يعلم أنه يموت أو يعجز أو لا يكون المأمور به مصلحة بشرط أن يبقى ويقدر ويكون الفعل مصلحةدليلنا هو أن معنى قولنا إن الله سبحانه قد أمر بالفعل بشرط زوال المنع هو أنه قال لنا افعلوه وأراده منا أو كان لنا فيه غرض مع فقد المنع ولم يرده مع وجوده لأنه لو أراده في الحالين لكان قد كلف إيقاع الفعل مع وجود المنع ولما كان قد أراده بشرط زوال المنع فاذا علم الله سبحانه أن المنع يحصل لا محالة فقد علم الحالة التي لا غرض له في إيقاع الفعل فيها فلم يجز أن يريده فيها يبين ذلك أن الواحد منا لو أراد دخول زيد الدار إن دخلها عمرو ولم يرد دخلوه فيها إن لم يدخلها عمرو ثم علم بخبر نبي أن عمرا لا يدخلها فان هذا العلم يصرفه عن إرادة دخول زيد إليها وإنما يريد دخوله إليها لو دخلها عمرو وهذه إرادة مقدرة غير حاصلة وأيضا فلو أراد الله سبحانه الفعل بشرط زوال المنع لكان قد اراد من المكلف إيقاعه إن لم يحصل المنع والمفهوم من هذه اللفظة الشك ألا ترى أن من علم بالمشاهدة أن الشمس قد طلعت لا يقول إن كانت الشمس قد طلعت دخلت الدار وإنما يحسن أن يقول ذلك إذا كان شاكا في طلوعها والبارىء
سبحانه عالم بأن المنع سيوجد فلم يجز أن يريد الفعل إن لم يحصل المنع وهذا الذي ذكرناه يمنع من تكليف الله سبحانه من يعلم أنه يتعذر عليه الفعل بجميع ضروب التعذر
وحجة المخالف أشياء
منها أن يقول قد أجمعنا على أن الله عز و جل قد كلف المعدوم والعاجز بشرط أن يقدر في حال الحاجة إلى القدرة والجواب أنا نقول إن الله سبحانه كلف بشرط أن يقدر ومعنى ذلك أن حكمنا بأن الله تعالى قد كلف الفعل مشروط بأن يكون ممن يقدر في وقت الحاجة فالشرط داخل على حكمنا لا على تكليف الله سبحانه ويشبه أن يكون المخالف هذا يعني بقوله إن الله سبحانه يكلف بشرط زوال المنع فان عني ذلك فلا حاجة فيه وجواب آخر وهو أن الذي ذكروه ليس يشبه موضع الخلاف وذلك أن كلامنا في أن يأمر الله تعالى بشرط يعلم أنه لا يوجد فأوردوا أن يأمر الله تعالى بشرط يعلم وجوده على أنا نقول إن الله يأمر المعدوم بشرط أن يوجد ونعني به أن الأمر الذي صدر من الله تعالى أمر له عند وجوده أو إذا وجد هذا ليس بمحال فيبطل ما قالوا
ومنها أن يقول إن الله سبحانه قد كلف الكافر بالصلاة بشرط أن يؤمن مع أنه علم بأنه لا يؤمن ولهذا يعاقبه على ترك الصلاة كما يعاقبه على الكفر والجواب أنا نقول كلف الإيمان والصلاة جميعا ولم يكلفه فعل الصلاة مضامة للكفر فلم يدخل الشرط في التكليف وإنما دخل الشرط في فعله لأنه قيل له افعلهما فاذا لم يفعلهما فقد أخل بمصلحتين فاستحق العقاب على الإخلال بها
ومنها قياسهم تكليف الله سبحانه الفعل بشرط زوال المنع على تكليف الواحد منا غيره بشرط زوال المنع وهو قياس بغير علة والفرق بينهما أن
الواحد منا غير عالم بأن للمكلف حالة منع لا غرض له في إيقاع الفعل فيها والباريء عز و جل عالم بذلك يبين ما ذكرناه أنه يجوز أن يكلف الواحد منا غيره بشرط أن يبقى وأن يكون الفعل مصلحة ولا يجوز ذلك من الله سبحانه
ومنها قولهم لو رفع منع التكليف لكان من منع غيره من الصلاة فقد أحسن إليه لأنه قد أسقط عنه كلفة من غير توجه ذم إليه الجواب يقال لهم أليس عندكم أنه لا يلزمه الفعل مضافا للمنع وأنه يسقط الفعل عنه من غير لوم فالسؤال يلزمكم كما يلزمنا وعلى أنه لا يكون محسنا إليه بالمنع مما يستحق به الثواب الجزيل
ومنها قولهم لو أسقط المنع التكليف على كل حال لما علم الواحد منا أنه مكلف للصلاة قبل تشاغله بها وذلك يسقط عنه وجوب أخذ الأهبة لها الجواب يقال لهم هذا يلزمكم أيضا لأن عندكم أن مع المنع لا تلزم الصلاة ولا أريدت من المكلف في تلك الحال وإنما أريدت منه بشرط زوال المنع وهو لا يعلم أن المنع يزول فاذا لا يعلم الوجوب فان لزمنا سقوط أخذ الأهبة فقد لزمكم وقد قال أصحابنا إنما يجب أخذ الأهبة للصلاة لثبوت أمارة بقائه سالما إلى وقتها فوجب عليه لهذه الأمارة التحرز من ترك ما لا يأمن وجوبه
باب في الامر المقيد بشرط هل يعلم أن الحكم فيما عدا الشرط بخلاف الشرط
أم لااعلم أن حكم الأمر وغيره إذا علق بشرط فإن الشرط يدل على أن الحكم لا يثبت فيما عداه على كل حال ولا يمنع الشرط من قيام الدلالة على شرط آخر يقوم مقامه ومتى فقدنا دلالة تدل على شرط ثان قضينا بأنه لا شرط إلا
الأول فنعلم أنه إذا انتفى الشرط انتفى الحكم على كل حال وإن دل دليل على شرط آخر علمنا انتفاء الحكم إذا انتفى الشرطان وإن علمنا ثبوت الحكم مع انتفاء الشرط على كل حال علمنا أن ذلك ليس بشرط وأنه قد يجوز به وقال قاضي القضاة إن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على أن ما عداه بخلافه وأنه يجوز أن يقوم شرط آخر مقام ذلك الشرط وحكاه عن أبي عبد الله وحكى عن الشيخ أبي الحسن أنه يدل على أن ما عداه بخلافه ومنع لذلك من الحكم بالشاهد واليمين لأن الله سبحانه شرط في الحكم الشاهد الثاني لأنه قصر الحكم على الشاهدين فلو لم يكن الثاني شرطا لم يكن لذكره معنى قال وإذا كان شرطا لم يجز الحكم مع فقده
والدليل على أن الشرط يمنع من ثبوت الحكم مع عدمه على كل حال أن قول القائل لغيره ادخل الدار إن دخلها عمرو معناه أن الشرط في دخولك هو دخول عمرو لأن لفظة إن موضوعة للشرط ولو قال له شرط دخولك الدار دخول عمرو علمنا أنه لم يوجب عليه دخول الدار مع فقد دخول عمرو على كل حال فكذلك في مسالتنا يبين ما قلناه أن الشرط هو الذي يقف عليه الحكم وعلى ما يقوم مقامه فلو ثبت الحكم مع عدمه على كل حال لكان كل شيء شرطا في كل شيء حتى يكون دخول زيد الدار شرطا في كون السماء فوق الإرض وإن وجد ذلك مع عدم الدخول ويدل على أن المعقول من الشرط ما ذكرناه ما روى أن يعلى بن منية سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 6 فلو لم يعقل من الشرط نفى الحكم عما عداه لم يكن لتعجبهما معنى وأجاب عن ذلك قاضي القضاة فقال لا يمتنع أن يكونا إنما تعجبا من ذلك لأنها عقلا من الآيات الواردة في وجوب الصلاة وجوب الإتمام وأن حال
الخوف مستثناة من ذلك والباقي ثابت على أصله في الإتمام فلذلك تعجبا من ثبوت القصر مع الأمن ولقائل أن يقول الآيات لا تنطق بالإتمام ولا كان الأصل في الصلاة الإتمام فنتم ما ذكر بل المروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت صلاة السفر والحضر ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وإذا كان كذلك لم يكن لتعجب عمر ويعلى بن منية سبب إلا الشرط وبطل القول بأن الأصل كان الإتمام فان قيل لو منع الشرط من ثبوت الحكم مع عدمه لما ثبت القصر مع عدم الخوف قيل إن ظاهر الشرط يمنع من ذلك وليس يمتنع أن تدل دلالة على خلاف الظاهر كما تدل دلالة على خلاف ظاهر العموم ولا يمتنع أن يكون الشرط قد ورد ليؤكد حال المشروط ولأن السبب في نزول إباحة القصر هو حال الخوف فشرط لأن الحال اقتضته
فان قيل ليس يمتنع أن تكون الفائدة في ورود الشرط تأكيد حال المشروط بأن يكون الحكم لو ورد مطلقا لظن المكلف أن المشروط لم يرد فيشرط لإزالة هذا الظن لا لأن الحكم لا يثبت مع فقده نحو أن يقول الله تعالى ضحوا بالشاة إن كانت عوراء لأنه لو قال ضحوا بالشاة لجاز أن يتوهم متوهم أنه لم يرد العوراء قيل إنا لم نقل إن الشرط يمنع من ثبوت الحكم مع فقده لأنه لا فائدة فيه إلا ذلك فيبطل قولنا بإيراد فائدة سواه وإنما قلنا ذلك من جهة أن لفظة إن وضعت موضع قولنا الشرط في هذا الحكم كذا وكذا وهذا اللفظ يفيد ما ذكرناه لأن معنى الشرط الحكم أن يقف عليه على ما يقوم مقامه وعلى أن العادة جرت أن يقول الإنسان لغيره ضح بالشاة وإن كانت عوراء ولا يقول إن كانت عوراء وإذا قال وإن كانت عوراء فهم من ذلك عطفها على الصحيحة كأنه أضمر جواز الأضحية بالصحيحة ثم عطف عليها العوراء
إن قيل لو منع الشرط من ثبوت الحكم مع فقده لكان قول الله
سبحانه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا يدل على أنه حظر الإكراه على البغاء إذا لم يردن التحصن قيل ليس كذلك لأنه إنما شرط إرادة التحصن لأن الإكراه على البغاء لا يحصل إلا وهن مريدات للتحصن فلهذا شرط لا لأن الحكم لا يثبت إلا مع إرادة التحصن وإنما قلنا إن الشرط لا يمنع من قيام دلالة على ثبوت شرط آخر لأن قول القائل لغيره أعط زيدا درهما إن دخل الدار ليس يتعرض لشرط آخر بنفي ولا إثبات ألا ترى أنه ليس فيه ذكر له فلم يمنع منه ولم يوجبه إن قيل قوله إن دخل الدار معناه الشرط في عطيتك دخوله الدار وهذا يقتضي أن كمال الشرط هو دخول الدار لأن لام الجنس تقتضي الشمول قيل بل قوله إن دخل الدار يفيد أن دخوله الدار شرط وذلك لا يمنع من ثبوت شرط آخر وليس له أن يقدر ذلك بزيادة ألف ولام لأن ذلك زيادة لا دليل عليها إن قيل ألستم قد قلتم إن قوله أعط زيدا درهما إن دخل الدار يمنع من العطية مع فقد الدخول أفليس إذا حصل شرط آخر فقد أعطاه مع عدم الدخول فهلا قلتم إن ظاهر الشرط يمنع من ثبوت شرط آخر وأنه لا يجوز إثباته إلا لدليل يدل عليه خلاف ظاهر الشرط الأول قيل إنا نقول إن قوله أعطه إن دخل الدار يفيد أن العطية مع فقد هذا الدخول على كل حال غير مباحة بل لا بد من حالة من الحالات تكون فيها العطية غير مباحة إذا فقد الدخول وليس يدخل تحت ذلك إذا قام شرط آخر مقام هذا الشرط لأنه إذا قام مقامه شرط لم تجز العطية إلا مع كل واحد منهما فلا تكون العطية مباحة مع فقد الشرط الأول على كل حال وقلنا إن الشرط لا يمنع ظاهرة من ثبوت شرط آخر لأنه ليس فيه ذكر لنفي شرط آخر ولا إثباته فلا تناقض بينهما
وأما الدلالة على أنه إذا لم تدل دلالة على شرط ثان لم نثبته فهي أنه لو كان
للحكم شرط آخر لدل الله سبحانه عليه فاذا لم يدل عليه علمنا نفيه كما نقول في صلاة سادسة
وأما قول الشيخ ابي الحسن إن الشاهد الثاني شرط في الحكم فان أراد به أنه ذكر بلفظ الشرط فمعلوم أنه ليس في الآية لفظ شرط وإن أراد أن الحكم لا يجوز مع فقده على كل حال فذلك صحيح وإن اراد أنه لا يجوز في حال ويجوز في حال فهكذا يقول من يذهب إلى الشاهد واليمين فانه لا يجوز الحكم بالشاهد الواحد ويجوز الحكم بالشاهد واليمين كما يجوز برجل وامرأتين وإن منع من الحكم بالشاهد واليمين لأنه زيادة على النص والزيادة على النص نسخ فلم يجز نسخ القرآن بخبر الواحد فذلك كلام في الزيادة على النص وسيأتي في موضعه إن شاء الله
باب في الأمر إذا قيد بغاية وحد
اعلم أن الحكم إذا علق بغاية وحد منع ظاهرهما من ثبوت الحكم بعدهما لأن قوله سبحانه ثم أتموا الصيام إلى الليل يجري مجرى أن يقول صوموا صوما غايته ونهايته وآخره وطرفه الليل لأن إلى موضوع للغاية والحد ولو قال ذلك لمنع من وجوب الصوم بعد مجيء الليل لأنه لو وجب أن يصوم بعد ذلك خرج الليل من أن يكون آخرا للصوم ودخل في أن يكون وسطا للصوم ولا يمتنع مع ذلك أن تدل دلالة على خلاف ظاهر الغاية فتوجب علينا صيام قطعة من الليل وتدل على أنه إنما سمي أول النهار طرفا للصوم مجازا من حيث كان قريبا من آخره فأما قاضي القضاة فانه قال إن الغاية تدل على أن ما بعدها بخلافها قال لأن الفائدة في ضرب الغاية زوال الحكم بعدها وهذا دعوى لا فرق بينه وبين قول القائل الفائدة فيذكر الصفة انتفاء الحكم مع انتفائها فأما نحن فقد بينا أن لفظة الغاية تفيد ما ذكرناه لا الفائدة
باب في الامر إذا قيد بعدد كيف القول فيه
اعلم أن من الناس من قال إن الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه ومنهم من قال لا يدل على ذلك كتعليق الحد بالثمانين ونحن نقول إنه ينبغي أن ينظر هل يدل تعليق الحكم بالعدد على حكم ما زاد عليه أم لا وهل يدل على حكم ما نقص منه أم لا فنقول إنه لا يدل على نفي الحكم عما زاد على العدد لأنه يجوز أن يكون في تعليقه بذلك العدد فائدة سوى نفيه عن الزيادة على ما سنذكره في دليل الخطابوقد يدل على ثبوت الحكم في الزيادة من جهة الأولى فان قول النبي صلى الله عليه و سلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا نعلم منه أن ما زاد عليها أولى بأن لا يحمل الخبث لأن القلتين موجودتان في الثلاث وزيادة ولو حظر الله علينا جلد الزاني مائة لكان حظر ما زاد على المائة أولى لأن المائة موجودة في المائتين وزيادة فأما إذا أباحنا جلد الزاني مائة أو أوجبه علينا فانه لا يدل على حكم ما زاد على ذلك لأنه ليس في اللفظ ذكر للزيادة ولا يقتضيه من جهة الأولى والفائدة
فأما تعليق الحكم بالعدد هل يدل على حكم ما نقص منه فانه ينظر فيه فان كان الحكم إيجابا فانه يدل على وجوب ما نقص عنه لأنه داخل تحته ويمنع من الاقتصار على ما دونه لأن الأمر قد أوجب استكمال العدد نحو أن يوجب الله سبحانه علينا جلد الزاني مائة فنعلم وجوب جلد خمسين وحظر
الاقتصار على ذلك وإن كان الحكم المعلق على العدد إباحة فانه يدل على إباحة ما دونه مما دخل تحته ولا يدل على إباحة ما دونه مما لم يدخل تحته مثال الأول يبيحنا جلد الزاني مائة فنعلم إباحة جلده خمسين وإذا علمنا أن الإباحة غير مقصورة على الخمسين لأن الخمسين داخلة تحت المائة وإذا أباحنا استعمال القلتين إذا وقعت فيها نجاسة علمنا إباحةاستعمال قلة منها ومثال الثاني أن يبيحنا استعمال القلتين فلا يدل ذلك على استعمال قلة واحدة وقعت فيها نجاسة ليست من جملة القلتين وكذلك إذا أباحنا الحكم بشهادة شاهدين فانه لا يدل على الحكم بشهادة شاهد واحد
فأما تعليق الحظر بالعدد فانه لا يدل على حكم ما دونه إلا من جهة الأولى فان الله سبحانه لو حظر علينا استعمال قلتين وقعت فيهما نجاسة لكان حظر قلة واحدة وقعت فيها نجاسة أولى ولو حظر علينا جلد الزاني مائة لم يدل على حظر ما دونه ولا على إباحته بل ذلك موقوف على الدليل لما سنذكره في دليل الخطاب فبان أن تعليق الحكم على العدد لا يدل على نفي ما زاد عليه أو نقص عنه ولا على إثبات ما زاد عليه أو نقص إلا باعتبار زائد
واحتج المخالف بأن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد المذكور لم يكن لذكر العدد فائدة والجواب عن ذلك ما سنذكره في دليل الخطاب وقالوا قد عقل النبي صلى الله عليه و سلم من قول الله سبحانه إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم أن ما زاد السبعين بخلاف السبعين فقال صلى الله عليه و سلم لأزيدن على السبعين وعقلت الأمة من جعل الجلد ثمانين حظر ما زاد عليه والجواب أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما علم ذلك بالبقاء على حكم الأصل لأن الأصل جواز العفو فلما علق الله سبحانه المنع من ذلك على السبعين بقي ما زاد على السبعين على حكم الأصل والأصل أيضا حظر الجلد فلما أوجب
الله سبحانه جلد القاذف ثمانين بقي ما زاد عليه على حكم الأصل فلهذا حظرت الأمة ما زاد على الثمانين
باب في الامر المقيد بالاسم
ذهب الجمهور إلى أن الإيجاب والأخبار المقيدة بالأسامي لا تدل على حكم ما عداها نحو قول القائل زيد في الدار لا يدل على أن عمرا في الدار ولا على أنه ليس في الدار وكذلك إذا أمر بشيء فانه لا يدل على ان غيره ليس بواجب وقال بعضهم إن تعليق الحكم بالاسم يدل على أن ما عداه بخلافهودلينا أن قول القائل زيد آكل لا يفهم منه أن عمرا ليس بآكل وأيضا لو دل على ذلك لما حسن من الإنسان أن يخبر به إلا بعد أن يعلم أن غير زيد ليس بآكل لأنه إن لم يعلم ذلك كان قد أخبر بما يعلم أنه كاذب فيه أو بما لا يأمن أن يكون فيه كاذبا وفي علمنا باستحسان العقلاء الإخبار بأن زيدا آكل مع شك المخبر في كون غيره آكلا بل مع علمه بأن غير زيد آكل دليل على ما قلناه وأيضا فلو دل قولنا زيد آكل على أن غيره ليس بآكل لم يخل إما أن يدل عليه لفظا أو من حيث خصه بالذكر فالأول باطل لأنه ليس في اللفظة ذكر لعمرو ولا لغيره والثاني أيضا باطل لأن الإنسان قد يعلم أن زيدا وعمرا قد اشتركا في فعل ويكون له غرض في الإخبار عن أحدهما ولا يكون له غرض في الإخبار عن الآخر وقد يعلم أن الفعل يجب عليهما فيخص أحدهما بالأمر به ويدل الأخر على وجوب الفعل بلفظ آخر وبدليل آخر فإذا أمكن ذلك لم يدل الاختصاص على ما ذكروه
فان قالوا إذا أمر احدهما ولم يدل الاخر على وجوب الفعل علمنا أنه
غير واجب عليه إذ لو كان واجبا عليه لدل على وجوبه قيل فاذا الدال على سقوط الوجوب فقد دلالة الوجوب لا تعلق الأمر بزيد ألا ترى أن الأمر لو لم يتوجه إلى زيد لعلمنا نفي الوجوب عن عمرو بفقد دلالة الوجوب فعلمنا أن هذا هو الدليل لا ما ذكرتم
فإن قالوا إذا علق الله سبحانه الحكم على الاسم الخاص ولم يعلقه على الاسم العام علمنا أنه غير متعلق عليه إذ لو تعلق عليه لعلقه الله سبحانه عليه وذلك نحو أن يقول في الغنم الزكاة فنعلم أنه لو كانت الزكاة في النعم لعلق الزكاة عليها والجواب أن هذا يقتضي أن نعلم نفي الزكاة عما سوى الغنم لفقد دلالة تدل على وجوب الزكاة فيها لا لتعلق الحكم على الغنم وعلى أنه لا يمتنع أن تكون المصلحة أن يبين لنا حكم الغنم في ذلك الوقت بذلك الكلام ويبين لنا حكم غيرها بكلام آخر في وقت آخر
باب في الامر المقيد بصفة
اختلف الناس في ذلك فقال معظم أصحاب الشافعي لو قال النبي صلى الله عليه و سلم زكوا عن الغنم السائمة لدل على أنه لا زكاة في غير السائمة واختلف هؤلاء في الخطاب المعلق بالاسم نحو قوله زكوا عن الغنم فقال معظمهم لا يدل على أن لا زكاة في غيرها وقال الأقلون يدل على ذلك وقال قوم إن الأمر وغيره إذا قيد بصفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه وهو معظم المتكلمين ومعظم أصحاب أبي حنيفة واختلف هؤلاء في الخطاب المقيد بلفظة إنما فقال قوم لا يدل على أن ما عداه بخلافة وقال قوم منهم بل يدل على ذلك نحو قول الله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واختلفوا أيضا في الخطاب المعلق بشرط والخطاب المعلق بعدد فمنهم من أجراه مجرى الخطاب المعلق بصفة في أنه لا يدل على أن ما عداه بخلافة ومنهم من قال يدل على حكم ما عداه وخالف بينه و بين المعلق بصفة
وأما الخطاب المعلق بغاية فإنهم اتفقوا على أنه يعلم أن ما عدا الغاية بخلافها وقال الشيخ أبو عبد الله إن الخطاب المعلق بالصفة يدل على نفي الحكم عما عداها في حال ولا يدل عليه في حال فالحالة التي يدل فيها على ذلك أحد أمور ثلاثة إما أن يكون الخطاب واردا مورد البيان نحو قول النبي صلى الله عليه و سلم في سائمة الغنم الزكاة وإما أن يكون واردا مورد التعليم نحو خبر التحالف والسلعة قائمة وإما ان يكون ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة نحو الحكم بالشاهدين يدل على نفيه عن الشاهد الواحد لأنه داخل تحت الشاهدين
والدليل على أن الخطاب المقيد بالصفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه هو أنه لو دل عليه لدل عليه إما بصريحه ولفظه وإما بفائدته ومعناه وليس يدل عليه من كلا الوجهين فأذا ليس يدل عليه
فأما صريحه فإنه ليس فيه ذكر لما عدا الصفة ألا ترى أن قول القائل أدوا الزكاة عن الغنم السائمة ليس فيه ذكر المعلوفة فإن قيل أليس قول الله سبحانه فلا تقل لهما أف يدل بصريحه على المنع من ضربهما وليس في لفظه ذكر الضرب قيل الصحيح أنه إنما يدل من جهة الفحوى والأولى لأنه لما نهى عن القليل من الأذى كان بأن يمنع من الكثير من الأذى أولى على ما سنبينه فأما أن الخطاب المعلق بالصفة لا يدل على أن الحكم مع نفيها من جهة المعنى فهو أنه لو دل على ذلك لكان إنما يدل عليه بأن يقال إذا قال النبي صلى الله عليه و سلم في الغنم السائمة زكاة علمنا أنه لو
كانت الزكاة في غير السائمة كما هي في السائمة لما تكلف ذكر السوم ولعلق الزكاة باسم الغنم لأن تكلف ذكر السوم مع تعلق الزكاة على مطلق اسم الغنم تكلف لما لا فائدة فيه وهذا باطل لأن في تكلف ذكر السوم فوائد أخر سوى نفي الزكاة عن المعلوفة وإذا أمكن ذلك بطل القول بأنه لا فائدة في ذكر السوم إلا انتفاء الزكاة عن المعلوفة يبين ما قلناه أنه قد يكون اللفظ لو أطلق في بعض المواضع لتوهم متوهم أن الصفة خارجة منه فيذكر الصفة لإزالة هذا الإيهام ويستدل من الجهة الأولى على ثبوت الحكم مع فقدها نحو أن يعلم الله سبحانه أنه لو قال ضحوا بشاة لتوهم متوهم أنه لم يرد العوراء فيقول ضحوا بشاة عوراء فيعلم جواز الأضحية بها وينبه بذلك على أن جواز الأضحية بالصحيحة أولى ولو قال الله سبحانه ولا تقتلوا أولادكم لتوهم متوهم أنه لم يرد قتلهم بخشية الإملاق فيقول الله سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لهذا الغرض
ومنها أن تكون البلوى قد وقعت بالصفة المذكورة وما عداها لم يشتبه على الناس فيقيد الله سبحانه الخطاب بالصفة نحو قوله سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق
ومنها أن تكون المصلحة أن نعلم حكم الصفة بالنص ونعلم حكم ما عداها بالقياس عليها وليس يمتنع ذلك كما لم يمتنع أن تكون المصلحة أن نعرف حكم الستة أجناس بالنص ونعرف حكم ما عداها بالقياس عليها وإذا لم يمتنع ذلك جاز أن يدلنا الله سبحانه على حكم الصفة نصا وينبهنا على ثبوت الحكم مع نفيها من جهة القياس
ومنها أن تكون المصلحة أن نعرف حكم الصفة بنص ونعرف ثبوت ذلك الحكم فيما عداها بنص آخر ألا ترى أنه قد تكون المصلحة أن نعرف الحكم
تارة بخطاب وجيز وتارة بخطاب طويل وتارة بأن يقول النبي صلى الله عليه و سلم في الغنم زكاة وتارة بأن يقول في الغنم السائمة وفي المعلوفة زكاة وإذا جاز أن يقرن ذلك إلى قوله في الغنم السائمة فلم لا يجوز أن يفصل بينهما بأن يقدم ذكر المعلوفة على ذكر السائمة
ومنها أن تكون المصلحة أن نعرف حصول الحكم فيما عدا الصفة بحكم العقل نحو أن يكون الحكم المعلق بصفة حكم العقل مثاله أن يقول النبي صلى الله عليه لا تذبحوا الغنم السائمة أو لا زكاة فيها فيبقى على نفي الزكاة عن المعلوفة وعلى تحريم ذبحها لأن ذلك هو حكم العقل
ومنها أن تكون المصلحة أن يبقى الحكم مع نفي الصفة بقاء على حكم العقل لا لثبوت الحكم مع الصفة نحو أن يقول النبي صلى الله عليه في الغنم السائمة زكاة ولا نجد دليلا شرعيا يدلنا على ثبوتها في المعلوفة فتنفي الزكاة عن المعلوفة بقاء على حكم العقل وتكون مصلحتنا أن نعلم ذلك بالعقل
فأن قيل فاذا عرفتم بطلان هذه الأقسام كلها لم تجدوا دليلا يدل على ثبوت الزكاة في المعلوفة فنفيتم الزكاة فقد صرتم إلى مذهبنا قيل ليس الأمر كذلك لأنكم أنتم تنفون الزكاة عن المعلوفة لأجل تعليقها على السائمة ونحن ننفيها عن المعلوفة لأنه حكم العقل ولم ينقلنا عنه دليل شرعي وبين الأمرين فرقان يبين ذلك أن استدلالنا نحن لا يقف على تعليق الزكاة على السوم بل سواء علقت عليه أو لم تعلق واستدلالكم يقف على تعليق الزكاة على السوم ونحن إنما نطلب هل في الشرع ما يدل على ثبوت الزكاة في المعلوفة أم لا لنعلم هل في الشرع ما يمنع من حكم العقل وإطلاقه أم لا وأنتم تطلبون هل في الشرع ما يدل على ثبوت الزكاة في المعلوفة لتنظروا هل في الشرع ما يمنع من دلالة تعلق الحكم على الصفة على نفيه عما عداها أم لا ويبين الفرق بيننا أنه لو كان المعلق بالصفة هو حكم العقل بأن يقول النبي صلى الله عليه و سلم لا تذبحوا السائمة لحرمنا ذبح المعلوفة بقاء على حكم الأصل إذا لم ينقلنا على
ذلك دليل شرعي وأنتم تبيحون ذبح المعلوفة لأجل حظر ذبح السائمة فقد بان الفرق بين الطريقتين فان قيل أيجوز ان يكون الحكم إنما علق بالسوم لأنه منتف عما عداه قيل يجوز ذلك ويجوز ما ذكرناه فلذلك توقفنا فيه فان قالوا إنه وإن جاز ما ذكرتموه من الفوائد فالظاهر أنه إنما علق الحكم بالسوم لأجل انتفائه عما عداه لا لما ذكرتم قيل ليس ها هنا لفظ متناول للفوائد فيقال إن الظاهر منه وقوعه على بعضها دون بعض فان قالوا معنى قولنا الظاهر يقتضي ما قلناه أن الأكثر من الحكم إذا علق على صفة أنه لا فائدة فيه إلا لأجل انتفائه عما عداه قيل لهم لم زعمتم أن الأكثر والأغلب ما قلتم وعلى أنه لو كان الأكثر من الفائدة والأغلب ما قلتم لأدى ذلك إلى غالب الظن بأنه إنما علق الحكم بالصفة لانتفائها عما عداها ولا يؤدي إلى القطع ألا ترى أنه يجوز ما قلناه من الفوائد وإن كان قليلا نادرا
دليل قد استدل بعضهم على أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفيه عما عدا الصفة من جهة الفائدة فقال لو لم يكن في ذلك فائدة إلا إذا كان الحكم منتفيا عما عدا الصفة لما جاز أن يدل دلالة منفصلة على ثبوت الحكم فيما عداها لأن الدلالة إذا دلت على ذلك فقد دلت على إبطال فائدة الخطاب وذلك لا يجوز في خطاب الحكيم فان قالوا إنما نقول إن الحكم لو ثبت فيما عدا الصفة لما كان لذكر الصفة فائدة إذا كان المتكلم قد خص الصفة بالحكم وإنما يكون قد خصها بالحكم إذا لم يدل دلالة على ثبوت الحكم مع عدمها قيل لهم فيجب استدلالكم على انتفاء الحكم فيما عدا الصفة على أن تفحصوا عن الأدلة فلا يجدوا دليلا عقليا ولا سمعيا يدل على ثبوت الحكم مع انتفاء الصفة وليس هذا من مذهبكم بل من مذهبكم أن نفس تعلق الحكم بالصفة يدل على انتفائه عما عداها وإنما تفتشون عن الأدلة لتعلموا هل فيها ما يعارض هذا الدليل أم لا فلا تفتشون عنها لأن استدلالكم بدليل الخطاب موقوف على ذلك كما يفتش أصحاب العموم عن الأدلة ليعلموا هل فيها ما يخص العموم أم لا ولا يفتشون عنها لأن استدلالهم بالعموم موقوف عليه فان
قالوا إنما يجوز قيام الدلالة على ثبوت الحكم فيما عدا الصفة ولا يكون ذلك مبطلا لفائدة تعليق الحكم بالصفة لأن الظاهر من تعليق الحكم بالصفة انتفاؤه عما عداها وليس يمتنع قيام الدلالة على خلاف الظاهر كما نقوله في تخصيص العموم قيل قد بينا أنه لا يمكن أن يقال فيما ليس بلفظ أن الظاهر منه كيت وكيت إلا على معنى الأكثر والأغلب وإن ذلك إنما يفيد غالب الظن لا العلم
دليل آخر في المسألة لو دل الخطاب المتعلق بالصفة على حكم ما عداها لدل الخبر على ذلك ومعلوم أن الإنسان إذا قال زيد الطويل في الدار لم يدل على أن القصير ليس في الدار ولا على أنه فيها فكذلك الخطاب إذا كان أمرا فان قيل الفرق بين الأمر والخبر أن المخبر قد يكون له غرض في الإخبار عن زيد ولا يكون له غرض في الإخبار عن عمرو وأما المكلف فان غرضه أن يبين جميع ما يجب على المكلف فاذا قال زكوا عن الغنم السائمة علمنا أنه لو كانت الزكاة في جميع الغنم لعلق الزكاة بمطلق الاسم قيل إنه كما يجوز أن يكون غرض المخبر ما ذكرتم فقد يكون غرض المكلف أن يعرفنا حكم السوم بلفظ ويعرفنا حكم ما عدا السوم بلفظ آخر وبدليل ليس بلفظ وإذا جاز ذلك لم يفترقا
دليل آخر استدل الشيخ أبو عبد الله وقاضي القضاة فقالا إن تعليق الحكم بالصفة يجري مجرى تعليقه بالاسم وتعليقه بالاسم لا يدل على انتفائه عما عداه وأما تعليق الحكم بالاسم فقد بينا أنه لا يدل على انتفائه عما عداه وأما تعليق الحكم بالاسم فقد بينا أنه لا يدل على انتفائه عما عداه وأما أن تعليقه بالصفة يجري مجرى تعليقه بالاسم فبيان ذلك أن الاسم وضع ليتميز به بين المسمى من غيره وكذلك الصفة أضيفت إلى الاسم عند وقوع الاشتراك فيه ليتميز أحد المسمين من الآخر مثال ذلك وقوع اسم زيد على البصري والكوفي فنضيف البصري إلى زيد ليتميز به كما يتميز منه باسم يخصه لا
يشاركه فيه الكوفي وكما أن تعليق الحكم بذلك لا يدل على انتفائه عن الكوفي فكذلك تعليقه بالصفة ولمعترض أن ينقض ذلك بالغاية لأنها تخص الزمام وتجري مجرى اسم يختص بذلك الزمان ومع ذلك فان تعليق الحكم بها يدل على انتفائه عما عداها بخلاف الأسماء وينتقص بالشرط عند من قال إنه يدل على انتفائه عما عداه لأنه قد خص ما دخل عليه ألا ترى أنك إذا قلت اعط زيدا درهما إن دخل الدار فقد خصصت هذه الحالة بالعطية وميزتها كما تميزها باسم لو كان لها وقد دل على انتفاء الحكم عما عدا الشرط ولقائل أن يقول ولم إذا جرت الصفة مجرى الاسم في التمييز كان حكمها في كل شيء حكمه وما أنكرتم أنه ليس العلة في أن تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه كما ذكرتم فان قيل إنما لم يدل على ذلك لأنه ليس في اللفظ ذكر لما عدا الاسم وذلك قائم في الصفة قيل هذا عدول إلى دليل آخر يمكن الاعتماد عليه بنفسه وللمخالف أن يقول هذا إنما يدل على أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل من جهة اللفظ على نفيه عما عدا الصفة ولا يدل على انه لا يقتضي ذلك من جهة الفائدة
دليل آخر وقد استدل على ذلك فقيل قد فرق أهل اللغة بين المعطف وبين النقض فقالوا إن قول القائل اضرب الرجال الطوال والقصار عطف وليس بنقض فلو كان قوله اضرب الرجال الطوال يدل على نفي ضرب القصار لكان قوله والقصار نقضا لا عطفا ولقائل أن يقول إنما يدل على نفي ضرب القصار تخصيص الطوال بالذكر في الحال وإذا عطف عليهم القصار لم يكن قد خصهم في الخطاب بالذكر فلم يوجد الدلالة على نفي ضرب القصار على الحد الذي يدل معه وأتى بعدها ما ينقضها فيكون نقضا وليس كذلك إذا قال القائل لغيره ضربت زيدا الآن في هذا المكان لم أضربه الآن في هذا المكان لأن الكلام الأول يدل تصريحه على ضربه والآخر يدل تصريحه على نفي ضربه فكل واحد منهما قد وجد على الوجه الذي لكونه عليه يكون دليلا على ما يدل عليه اللهم إلا أن يكون المتكلم ما عني بهما شيئا
أو لم يعن بأحدهما شيئا فيكون قد لغا بهما أو بأحدهما وعلى أنه باطل بالغاية والشرط لأن الإنسان إذا قال لغيره صم إلى غروب الشمس أفاد ذلك نفي الصوم بعد غروبها ولو قال صم إلى غروب الشمس وإلى طلوع القمر لم يكن ذلك نقضا ولو قال أعط زيدا درهما إن دخل الدار ولم يدل دليل على ثبوت شرط آخر لم تثبت العطية إذا لم يدخل الدار ولو قال له أعطه درهما إن دخل الدار وإن دخل السوق أفاد وجوب العطية إن دخل السوق ولم يكن ذلك نقضا
وأما القول بأن تعليق الحكم بالصفة إذا خرج مخرج البيان دل على أن ما عداها بخلافه فلا يصح لأن اللفظ إنما يكون بيانا لمجمل إذا كان دالا إما بموضوعه أو بمعناه على المراد بالمجمل ومعلوم أن تعليق الحكم بالصفة ليس فيه ذكر ما عدا الصفة ولا يدل من جهة المعنى على ما عدا الصفة فلم يجز أن يقصد به البيان كما عدا الصفة إذا كان هناك آية مجملة فان قيل إذا كان هناك آية مجملة وورد بيان له يعلق بالصفة علمنا انتفاء الحكم عما عدا الصفة لعلمنا أن ما عدا الصفة لو أريد بالمجمل لبين لأن البيان لا يتأخر قيل إذا الدال على انتفاء الحكم عما عدا الصفة هو فقد البيان لا تعليق الحكم بالصفة ألا ترى أن الحكم لو لم يتعلق بالصفة لعلمنا انتفاؤه عما عداها إذا لم يجد بيان حكمهما لعلمنا أن البيان لا يتأخر
وأما القول بأن تعليق الحكم بالصفة يدل على حكم ما عداها إذا خرج مخرج التعليم فلقائل أن يقول إن كل خطاب النبي صلى الله عليه و سلم يتضمن حكما فهو خارج مخرج التعليم فلا معنى لهذه القسمة إلا أن يراد بذلك أن يعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قصد بذكر الصفة أن يعلق عليها جميع الحكم ومتى أريد ذلك فان الدال على انتفاء الحكم مع عدم الصفة هو علمنا من قصد النبي صلى الله عليه و سلم أنه قصر الحكم كله على الصفة
وأما القول بأن الحكم المعلق بالصفة يدل على أن ما عداها بخلافه إذا دخل