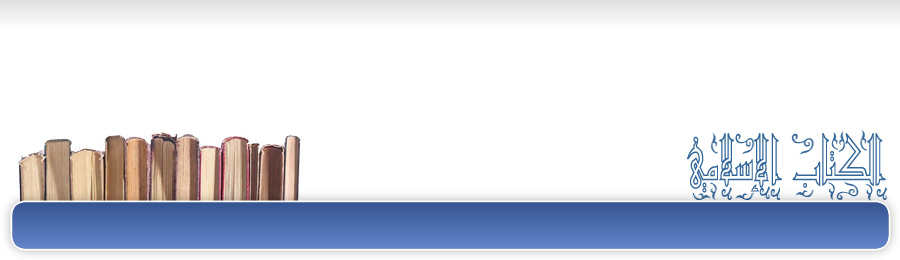الكتاب : أصول السرخسي
المؤلف : ابى بكر محمد بن احمد بن ابى سهل السرخسى
حرمة الاجتماع بين المتلاعنين، وبعد التعليل تكون حرمة الاجتماع بين غير المتلاعنين.
فإن قيل: فقد فعلتم ما أنكرتموه في فصول، منها أن حكم نص الربا المساواة بين القليل والكثير قبل التعليل، ثم بعد التعليل خصصتم القليل من الحنطة فلم يبق حكم النص بعد التعليل بالكيل في المنصوص على ما كان قبله.
وكذلك الشاة بصورتها ومعناها صار مستحقا للفقير بالنص، ثم بالتعليل بالمالية أبطلتم حقه عن الصورة فلم يبق حكم النص بعد التعليل في المنصوص على ما كان قبله، وجوزتم هذا التعليل لابطال حق المستحق مع أنه لا يجوز استعمال القياس في إبطال حق المستحق عن الصورة أو المعنى كما في سائر
حقوق العباد.
وقد ثبت بالنص حق الاصناف في الصدقات لوجود الاضافة إليهم بلام التمليك، ثم بالتعليل بالحاجة غيرتم هذا الحكم في المنصوص وجوزتم الصرف إلى صنف واحد.
وثبت بالنص وجوب التكفير بإطعام عشرة مساكين، ثم بالتعليل غيرتم هذا الحكم في المنصوص فجوزتم الصرف إلى مسكين واحد في عشرة أيام.
وبالنص ثبت لزوم التكبير عند الشروع في الصلاة، ثم بالتعليل بالثناء وذكر الله على سبيل التعظيم غيرتم هذا الحكم في المنصوص حتى جوزتم افتتاح الصلاة بغير لفظ التكبير.
وبالنص ثبت وجوب استعمال الماء لتطهير الثوب عن النجاسة، ثم غيرتم بالتعليل بكونه مزيلا للعين والاثر هذا الحكم في المنصوص حتى جوزتم تطهير الثوب النجس باستعمال سائر المائعات سوى الماء.
قلنا: أما الاول فهو دعوى من غير تأمل، وإنا ما خصصنا القليل من البر إلا بالنص، فإن النص قوله عليه السلام: لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء والاصل في الاستثناء من النفي أن المستثنى منه في معنى المستثني، وعلى هذا بنى علماؤنا مسائل: في الجامع: إذا قال إن كان في هذه الدار إلا رجل فعبده حر، فإذا في الدار سوى الرجل دابة أو ثوب لم يحنث، وإن كان فيها سوى الرجل امرأة أو صبي حنث.
ولو كان قال إلا حمارا فإذا فيها حيوان آخر سوى الحمار يحنث، وإن كان فيها ثوب سوى الحمار لم
يحنث، وإن كان قال إلا ثوب فأي شئ يكون في الدار سوى الثوب مما هو مقصود بالامساك في الدور يحنث، فعرفنا أن المستثنى منه في معنى المستثنى، والمستثنى هنا حال التساوي في الكيل، واستثناء الحال من العين لا يكون، فعرفنا بدلالة النص أن المستثنى من عموم الاحوال
حال التساوي وحال المجازفة وحالة التفاضل، وهذا لا يتحقق إلا في الكثير، وإلا فيما يكون مقدرا شرعا، فعرفنا أن اختصاص القليل كان بدلالة النص وأنه كان مصاحبا للتعليل لا أن يكون ثابتا بالتعليل.
وأما الزكاة فنحن لا نبطل بالتعليل شيئا من الحق المستحق لانه تبين خطأ من يقول بأن الزكاة حق الفقراء مستحقة لهم شرعا، بل الزكاة محض حق الله تعالى، فإنها عبادة محضة وهي من أركان الدين، وهذا الوصف لا يليق بما هو حق العبد، ومعنى العبادة فيها أن المؤدي يجعل ذلك القدر من ماله خالصا لله تعالى حتى يكون مطهرا لنفسه وماله، ثم يصرفه إلى الفقير ليكون كفاية له من الله تعالى، فإنه وعد الرزق لعباده وهو لا يخلف الميعاد، ومعلوم أن حاجات العباد تختلف، فالامر بإنجاز المواعيد لهم من مال مسمى يتضمن الاذن في الاستبدال ضرورة ليكون المصروف إلى كل واحد منهم عين الموعود له، بمنزلة السلطان يجيز أولياءه بجوائز مختلفة يكتبها لهم ثم يأمر واحدا بإيفاء ذلك كله من مال يسميه بعينه، فإنه يكون ذلك إذنا له في الاستبدال ضرورة والثابت بضرورة النص كالثابت بالنص، فعرفنا أن ذلك كان ثابتا بالنص ولكنه كان مجامعا للتعليل، ثم التعليل بحكم شرعي لا بحق مستحق لاحد، فإن المؤدى بعد ما صار لله تعالى بابتداء يد الفقير يكون كفاية له من الله باستدامة اليد فيه، وثبت بهذا النص كونه محلا صالحا لكفاية الفقير، وصلاحية المحل وعدم صلاحيته حكم شرعي كالخمر لا يكون محلا صالحا للبيع والخل يكون محلا صالحا له، وهذه الصلاحية تثبت بالامر بالصرف إلى الفقير، لان باعتبار كونه مطهرا يصير من جملة الاوساخ، وإليه أشار عليه السلام في قوله: يا معشر
بني هاشم إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس، وعوضكم منها خمس
الخمس فتبين أنه بمنزلة الماء المستعمل، ولهذا كان الحكم في شريعة من قبلنا أن الصدقات المقبولة والقرابين كانت تأكلها النار ولا يجوز الانتفاع بها، وفي شريعتنا لا يحل شئ منها للغني ويحل للفقير لحاجته، بمنزلة حل الميتة عند الضرورة، فعرفنا أن حكم النص صلاحية المحل للصرف إلى كفاية الفقير، وبعد التعليل تبقى هذه الصلاحية كما كانت قبلها ويتعدى حكم الصلاحية إلى سائر المحال كما هو حكم التعليل في القياس الشرعي، وبهذا يتبين أن اللام في قوله: للفقراء لام العاقبة، أي تصير لهم باعتبار العاقبة، ولكن بعد تمام أداء الصدقات يجعل المال لله بابتداء التسليم إلى الفقراء، أو يكون المراد بيان المصرف الذي يكون المال بقبضهم لله تعالى خالصا هو، لا بمنزلة الكعبة فإن الاركان باعتبار التوجه إليها تصير صلاة لا أن تكون الصلاة حقا للكعبة، ثم كل صنف من هذه الاصناف جزء من المصارف بمنزلة جزء من الكعبة، واستقبال جزء منها كاستقبال جميعها في حكم الصلاة وهو ثابت بالنص لا بالتعليل، فكذلك الصرف إلى صنف لما فيه من سد خلة المحتاج بمنزلة الصرف إلى الاصناف لا بطريق التعليل.
وحكم الاطعام كذلك، فإن حكم النص أن المساكين العشرة محل لصرف طعام الكفارة إليهم، وهذا الحكم باق في المنصوص بعد التعليل كما قبله، ولكن ثبت بدلالة النص للتنصيص على صفة المسكنة في المصروف إليه أن المطلوب سد الخلة، وعلم يقينا تجدد الحاجة للمسكين بتجدد الايام فصار بدلالة النص ما يقع به التكفير سد عشر خلات وهو ثابت بالصرف إلى مسكين واحد في عشرة أيام كما يثبت بالصرف إلى عشرة مساكين.
وأما التكبير فلا نقول حكم النص وجوب التكبير بعينه عند الشروع في الصلاة، ولكن الواجب التعظيم باللسان، لان اللسان من الاعضاء الظاهرة من وجه، والصلاة
تعظيم الله تعالى بجميع الاعضاء، فتعلق بكل عضو ما يليق به من التعظيم، ثم التعظيم
باللسان يكون بالثناء والذكر، فكان ذكر الله على سبيل التعظيم لتحقيق أداء الفعل المتعلق باللسان، ولا عمل لذلك الفعل في تعيين التكبير، بل التكبير آلة صالحة لذلك، وقد بقيت بعد هذا التعليل آلة صالحة لاقامة هذا الفعل بها كما قبل التعليل.
وكذلك غسل النجاسة بالمائعات فالمستحق ليس هو الغسل بعينه بل إزالة النجاسة عن الثوب حتى لا يكون مستعملا لها عند لبسه، ألا ترى أنه لو قطع موضع النجاسة بالمقراض أو ألقى ذلك الثوب أصلا لم يلزمه الغسل، ثم الماء آلة صالحة لازالة النجاسة باستعماله، وبعد التعليل يبقى كذلك آلة صالحة لازالة النجاسة لاستعماله، وحكم الغسل طهارة المحل باعتبار أنه لم يبق فيه عين النجاسة ولا أثرها، فكل مائع ينعصر بالعصر فهو يعمل عمل الماء في المحل، ثم طهارة المحل في الاصل وانعدام ثبوت صفة النجاسة في المزيل بابتداء ملاقاة النجاسة إلى أن يزايل الثوب بالعصر حكم شرعي ثبت بالنص، وبالتعليل تعدى هذا الحكم إلى الفروع وبقي في الاصل على ما كان قبل التعليل.
ولا يدخل على هذا التطهير من الحدث بسائر المائعات سوى الماء، لان عمل الماء في إزالة عين عن المحل الذي يلاقيه، أو في إثبات صفة الطهارة للمحل بواسطة الازالة، وليس في أعضاء المحدث عين تزول باستعمال الماء، فإن أعضاءه طاهرة، وإنما فيها مانع حكمي من أداء الصلاة غير معقول المعنى، وقد ثبت بالنص رفع ذلك المانع بالماء وهو غير معقول المعنى، وقد بينا أن مثل هذا الحكم لا يمكن تعليله للتعدية إلى محل آخر.
ولا يدخل على هذا الجواب تصحيح الوضوء بغير النية كغسل النجاسة، لان الذي لا يعقل المعنى فيه ما هو مزال عن المحل عند استعمال الماء،
فأما الماء في كونه مزيلا إذا استعمل في المحل معقول المعنى فلا حاجة إلى اشتراط النية لحصول الازالة به كما في غسل النجاسات، فعلم أن هذه الحدود إنما يقف المرء عليها عند التأمل عن إنصاف.
وأما بيان القسم الخامس ففيما قاله علماؤنا: إنه لا يجوز قياس السباع سوى
الخمس المؤذيات على الخمس بطريق التعليل في إباحة قتلها للمحرم وفي الحرم، لان في النص قال عليه الصلاة والسلام: خمس يقتلن في الحل والحرم وإذا تعدى الحكم إلى محل آخر يكون أكثر من خمس فكان في هذا التعليل إبطال لفظ من ألفاظ النص، بخلاف حكم الربا فإن النبي عليه السلام لم يقل الربا في ستة أشياء، ولكن ذكر حكم الربا في أشياء فلا يكون في تعليل ذلك النص إبطال شئ من ألفاظ النص.
ومن هذا النوع تعليل الشافعي حكم الربا في الاشياء الاربعة بالطعم فإن في النص قال عليه الصلاة والسلام: والفضل ربا: أي الفضل حرام يفسد به العقد لانه ربا، والتعليل بالطعم يبطل كون الفضل ربا، لانه يقول بعلة الطعم فساد البيع في هذه الاموال أصل إلى أن يوجد المخلص وهو المساواة في المعيار الشرعي، فيكون هذا إبطالا لبعض ألفاظ النص.
ومن ذلك تعليله لرد شهادة القاذف للفسق الثابت بالقذف، فإنه إبطال لبعض ألفاظ النص وهو قوله تعالى: (أبدا) فإن رد الشهادة باعتبار الفسق لا يتأبد، فكيف يتأبد وسببه وهو الفسق بعرض أن ينعدم بالتوبة، فكان هذا تعليلا باطلا لتضمنه إبطال لفظ من ألفاظ النص.
ومن جملة ما لا يكون استعمال القياس فيه طريقا لمعرفة الحكم، النذر بصوم يوم النحر، وأداء الظهر يوم الجمعة في المصر بغير عذر قبل أداء الناس
الجمعة، وفساد العقد لسبب الربا، فإن الكلام في هذه الفصول في موجب النهي وأن عمله بأي قدر يكون، والنهي أحد أقسام الكلام كالامر، فيكون طريق معرفته موجبة عند الاطلاق التأمل في معاني كلام أهل اللسان دون القياس الشرعي.
ومن ذلك الكلام في الملك الثابت للزوج على المرأة بالنكاح أنه في حكم ملك العين أو في حكم ملك المنفعة، فإنه لا مدخل للقياس الشرعي فيه، لان بعد النكاح نفسها وأعضاؤها ومنافعها مملوكة لها فيما سوى المستوفى منها بالوطئ على ما كان قبل النكاح، فإثبات ملك عليها بدون تمكن الاشارة
إلى شئ من عينها أنه مملوك عليها يكون حكما ثابتا بخلاف القياس، وقد بينا أن مثل هذا لا يقبل التعليل وأنه ملك ضروري ظهر شرعا لتحقق الحاجة إلى تحصيل السكن والنسل بمنزلة حل الميتة عند الضرورة فلا يقبل التعليل، ولان التعليل إنما يجوز بشرط أن يكون الفرع نظير الاصل في الحكم الذي يقع التعليل له، ولا نظير لملك النكاح من سائر أنواع الملك، لان سائر أنواع الملك يثبت في محل مخلوق ليكون مملوكا للآدمي، وهذا الملك في الاصل يثبت على حرة هي مخلوقة لتكون مالكة، وأي مباينة فوق المالكية والمملوكية، فإذا ثبت أنه لا نظير لهذا الملك من سائر الاملاك ثبت أنه لا يمكن المصير إلى التعليل فيه لمعرفة صفته.
ومن ذلك الكلام في موجب الالفاظ حتى يصير في الرهن أنه يد الاستيفاء حقا للمرتهن، بمنزلة اليد التي تثبت في المحل بحقيقة الاستيفاء، أم حق البيع في الدين، ثم اليد شرط لتتميم السبب كما في الهبة اليد شرط لتتميم السبب، والحكم ثبوت الملك في المحل بطريق العلة، فهذا مما لا يمكن إثباته (في القياس)
بالقياس الشرعي، لان أحكام العقود مختلفة شرعا ووضعا، وباعتبار الاختلاف يعلم أنه ليس بعضها نظيرا للبعض، ومن شرط صحة التعليل أن يكون الفرع نظيرا للاصل، بل طريق معرفة حكم الرهن التأمل فيما لاجله وضع هذا العقد وشرع، فنقول: إنه مشروع ليكون وثيقة لجانب الاستيفاء لا مؤكدا للوجوب، ألا ترى أنه يختص بالمال الذي هو محل للاستيفاء فأما محل الوجوب فالذمة، وإذا كان وثيقة لجانب الاستيفاء علم أن موجبه من جنس ما يثبت بحقيقة الاستيفاء، والثابت بحقيقة الاستيفاء ملك العين وملك اليد، ثم بالرهن لا يثبت ملك العين.
فعرفنا أن موجبه ملك يد الاستيفاء بمنزلة الكفالة فإنها وثيقة لجانب الوجوب ولهذا اختصت بالذمة، ثم كان موجبها من جنس ما يثبت بحقيقة الوجوب وهو ملك المطالبة، لان الثابت بالحقيقة ملك أصل الدين في ذمة من يجب عليه وثبوت حق المطالبة بالاداء، فالثابت بالوثيقة التي هي لجانب الوجوب من جنسه وهو حق المطالبة
حتى يملك مطالبة الكفيل بالدين مع بقاء أصله في ذمة المديون.
ومن ذلك الكلام في المعتدة بعد البينونة أنه هل يقع عليها الطلاق ؟ فإن تعليل الخصم بأنه ليس له عليها ملك متعة ولا رجعة لا يلحقها طلاقه كمنقضية العدة تعليل باطل، لان الخلاف في أن العدة التي هي حق من حقوق النكاح هل تكون بمنزلة أصل النكاح في بقائها محلا لوقوع الطلاق عليها باعتباره أم لا ؟ وفي منقضية (العدة) لا عدة، ففي أي وجه يستقيم هذا التعليل ليثبت به هذا الحكم للخصم ؟ وكذلك هذا التعليل في نكاح الاخت في عدة الاخت بعد البينونة من الخصم باطل، لان الكلام في أن العدة التي هي حق النكاح هل تقوم مقام النكاح في بقاء المنع الثابت بسبب النكاح أم لا ؟ وفي منقضية العدة لا عدة، وهذا لان النافي ينكر أن يكون الحكم مشروعا وما ليس
بمشروع كيف يمكن إثباته بالقياس الشرعي.
ومن هذا النوع تعليله في إسلام المروي في المروي، لان العقد جمع بدلين لا يجري فيهما ربا الفضل فكان بمنزلة الهروي مع المروي، لان الكلام في أن الجنس هل هو علة لتحريم النساء، وفي الهروي مع المروي لا جنس، وبهذا تبين أن حجة المدعي المثبت غير حجة المنكر النافي.
ومن هذا النوع الكلام فيما إذا قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة أن الرجعة تنقطع بهذا اللفظ أم لا ؟ فإن تعليل الخصم بأنه ما اعتاض عن طلاقها يكون تعليلا باطلا، لان الكلام في أن صفة البينونة هل هي مملوكة للزوج بالنكاح كأصل الطلاق أم لا ؟ فالخصم ينكر كون ذلك مملوكا له، ونحن نقول إن ذلك مملوك له وإنما لم يثبت بصريح لفظ الطلاق لا لانه غير مملوك له بل لانه ساكت عن هذه الصفة، فإن وصفها بالطلاق يجامع النكاح ابتداء وبقاء، فإنما طريق معرفة هذا الحكم التأمل في موضوع هذا الملك وفيما صار له أصل الطلاق مملوكا له، فإذا ثبت باعتباره أن الوصف مملوك له كان التصريح به بذلك الوصف عملا، وعند عدم التصريح به لا يثبت لان سببه لم يوجد، كما لا يثبت أصل الطلاق إذا لم يوجد منه التكلم بلفظ الطلاق أو بلفظ آخر قائما مقامه.
ومن هذا النوع تعليل الخصم في عقد الاجارة أنها توجب ملك البدل في الحال بالقياس على عقد البيع، فإن شرط صحة القياس أن يكون الاصل والفرع نظيرين، وفي باب البيع ما هو المعقود عليه قائم مملوك في الحال، وفي الاجارة ما هو المعقود عليه معدوم غير مملوك عند العقد، فعلم أنهما متغايران، وإذا لم يكن أحدهما نظيرا للآخر في الحكم الذي وقع التعليل لاجله لا يستقيم تعدية الحكم من أحدهما إلى الآخر بالقياس الشرعي.
ومن نوع ما بدأنا به هذا الفصل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للاعرابي في حديث كفارة الفطر كلها أنت وعيالك فإن من الناس من اشتغل بتعليل ذلك لتعدية الحكم إلى غير الاعرابي فيتطرق به (إلى) القول بانتساخ حكم الكفارة وذلك لا يجوز عندنا، لان النبي عليه السلام خص الاعرابي بصحة التكفير منه بالصرف إلى نفسه وعياله، وكان ذلك بطريق الاكرام له، وقد بينا أن مثل هذا لا يقبل التعليل، والله تعال أعلم.
فصل: في الركن ركن القياس هو الوصف الذي جعل علما على حكم العين مع النص من بين الاوصاف التي يشتمل عليها اسم النص، ويكون الفرع به نظيرا للاصل في الحكم الثابت باعتباره في الفرع، لان ركن الشئ ما يقوم به ذلك الشئ وإنما يقوم القياس بهذا الوصف.
ثم هذا الوصف قد يكون لازما للاصل وذلك نحو إيجاب الزكاة عندنا في الحلي باعتبار صفة الثمنية في الاصل، وعند الخصم إثبات حكم الربا في الذهب والفضة بعلة الثمنية والثمنية صفة لازمة لهذين الجوهرين، فإنهما خلقا جوهري الاثمان لا يفارقهما هذا الوصف بحال، وقد يكون عارضا أو اسما نحو قوله عليه السلام للمستحاضة في بيان علة نقض الطهارة: إنه دم عرق انفجر والدم اسم علم والانفجار صفة عارضة.
مثاله تعليل علمائنا نص
الربا بالكيل والوزن فإن ذلك وصف عارض يختلف باختلاف عادات الناس في الاماكن والاوقات، وقد يكون حكما نحو قول رسول الله عليه السلام للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته الحديث، فإن الدين عبارة عن الوجوب في الذمة، وذلك حكم قد بين لها حكما بالاستدلال بحكم آخر، وذلك دليل جواز التعليل بالحكم، وقد يكون هذا الوصف فردا
وقد يكون مثنى، وقد يكون عددا.
فالفرد نحو تعليل ربا النساء بوصف واحد وهو الجنس أو الكيل أو الوزن عند اتحاد المعنى، والمثنى نحو علة (حرمة) التفاضل، فإنه القدر مع الجنس، والعدد نحو تعليلنا في نجاسة سؤر السباع بأنه حيوان محرم الاكل لا للكرامة ولا بلوى في سؤره، وإنما يكون العدد من الاوصاف علة إذا كانت لا تعمل حتى ينضم بعضها إلى بعض، فإن كل وصف يعمل في الحكم بانفراده فإنه لا يكون التعليل بالاوصاف كلها، وقد يكون ذلك الوصف في النص، وقد يكون في غيره.
أما ما يكون في النص فغير مشكل، فإنه إنما يعلل النص والتعليل بوصف فيه يكون صحيحا لا محالة.
وأما ما يكون في غيره فنحو ما روي أن النبي عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم، فإن هذه الرخصة معلولة بإعدام العاقد وذلك ليس في النص، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الآبق وعن بيع الغرر، وهو معلول يعجز البائع عن تسليم المبيع أو جهالة في المبيع في نفسه على وجه يفضي إلى المنازعة وهذا ليس في النص، قال عليه السلام: لا تنكح الامة على الحرة ثم علل الشافعي هذه الحرمة بإرقاق الحر جزءا منه وهو الولد مع غنيته عنه وهذا ليس في النص، ولكن ذكر البيع يقتضي بائعا، وذكر السلم يقتضي عاقدا، وذكر النكاح يقتضي ناكحا، وما يثبت بمقتضى النص فهو كالمنصوص.
وكذلك عللنا نحن نهي رسول الله عليه السلام عن صوم يوم النحر بعلة رد الضيافة التي للناس في هذا اليوم من الله تعالى بالقرابين وذلك ليس في النص.
وكل نهي جاء لا لمعنى في عين المنهي عنه فهو من هذا النوع.
ومن التعليل بالحكم ما يقوله علماؤنا في بيع المدبر (إنه تعلق عتقه بمطلق الموت فإن التعلق حكم ثابت بالتعليق فيكون ذلك استدلالا) بحكم على حكم،
وإنما جاز هذا كله لان الدليل الذي يثبت به كون الوصف حجة في الحكم قد ثبت بالدليل أنه علة الحكم شرعا.
ثم لا خلاف أن جميع الاوصاف التي يشتمل عليها اسم النص لا تكون علة، لان جميع الاوصاف لا توجد إلا في المنصوص والحكم في المنصوص ثابت بالنص لا بالعلة، ولا خلاف أن كل وصف من أوصاف المنصوص لا يكون علة للحكم بل العلة للحكم بعضها، فإن الحنطة تشتمل على أوصاف فإنها مكيلة موزونة مطعومة مقتات مدخر حب شئ جسم، ولا يقول أحد إن كل وصف من هذه الاوصاف علة لحكم الربا فيها بل العلة أحد هذه الاوصاف.
واتفقوا أنه لا يتخير المعلل حتى يجعل أي هذه الاوصاف شاغلة من غير دليل، لان دعواه لوصف من بين الاوصاف أنه علة بمنزلة دعواه الحكم أنه كذا، فكما لا يسمع منه دعوى الحكم إلا بدليل فكذلك لا تسمع منه الدعوى في وصف أنه هو العلة إلا بدليل.
ثم اختلف العلماء في الدليل الذي به يكون الوصف علة للحكم.
قال أهل الطرد: هو الاطراد فقط من غير أن يعتبر فيه معنى معقول.
وتفسير الاطراد عند بعضهم: وجود الحكم عند وجود ذلك الوصف.
وعند بعضهم يشترط أن يوجد الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه، وأن يكون المنصوص عليه قائما في الحالين ولا حكم له.
وعند بعضهم يعتبر الدوران وجودا وعدما.
فأما قيام الحكم في المنصوص (عليه في الحالين) ولا حكم له فهو مفسد للقياس لا أن يكون مصححا له.
وقال جمهور الفقهاء: انعدام الحكم عند عدم العلة لا يكون دليل صحة العلة ووجود الحكم عند عدم العلة لا يكون دليل
فساد العلة، ولكن دليل صحة العلة أن يكون الوصف صالحا للحكم ثم يكون
معدلا بمنزلة الشاهد، فإنه لا بد من أن يكون صالحا للشهادة لوجود ما به يعتبر أهلا للشهادة فيه، ثم يكون معدلا بظهور عدالته عند التعديل، ثم يأتي بلفظ الشهادة من بين سائر الالفاظ حتى تصير شهادته موجبة العمل بها.
ثم لا خلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله أن صفة الصلاحية للعلة بالملاءمة، ومعناها أن تكون موافقة العلل المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة غير نائية عن طريقهم في التعليل، لان الكلام في العلة الشرعية، والمقصود إثبات حكم الشرع بها، فلا تكون صالحة إلا أن تكون موافقة لما نقل عن الذين بنيانهم عرف أحكام الشرع.
ثم الخلاف وراء ذلك في العدالة فقال علماؤنا: عدالة العلة تعرف بأثرها، ومتى كانت مؤثرة في الحكم المعلل فهي علة عادلة، وإن كان يجوز العمل بها قبل ظهور التأثير، ولكن إنما يجب العمل بها إذا علم تأثيرها ولا يجوز العمل بها عند عدم الصلاحية بالملاءمة، بمنزلة الشهادة فإن الشاهد قبل أن تثبت الصلاحية للشهادة فيه لا يجوز العمل بشهادته، وبعد ظهور الصلاحية قبل العلم بالعدالة كالمستور لا يجب العمل بشهادته، ولكن يجوز العمل حتى إن قضى القاضي بشهادة المستور قبل أن تظهر عدالته يكون نافذا.
وقال بعض أصحاب الشافعي: عدالة الوصف بكونه مخيلا، أي موقعا في القلب خيال الصحة للعلة ثم العرض على الاصول بعد ذلك احتياط.
وقال بعضهم: بل العدالة بالعرض على الاصول، فإذا لم يعارضه أصل من الاصول لا ناقضا ولا معارضا فحينئذ يصير معدلا وأدنى ما يكفي لذلك أصلان، بمنزلة عدالة الشاهد، فإن معرفة ذلك بعرض حالهم على المزكين وأدنى ما يكفي لذلك عنده اثنان، فعلى قول هذا الفريق من أصحابه لا يجوز العمل به وإن كان مخيلا قبل العرض على الاصول، وعلى قول الفريق الاول يجوز العمل به لانه صار معدلا بكونه
مخيلا.
ثم العرض على الاصول احتياط، والنقض جرح، والمعارضة دفع.
أما أهل الطرد احتجوا بالظواهر الموجبة للعمل بالقياس، فإنها لا تخص علة دون علة، فيقتضي الظاهر جواز العمل بكل وصف والتعليل به إلا ما قام عليه دليل، وأن كل وصف يوجد الحكم عند وجوده فإنه وصف صالح لان يكون علة، وهذا لان علل الشرع أمارات للاحكام وليست على نهج العلل العقلية، وأمارة الشئ ما يكون موجودا عند وجوده، وكما يجوز إثبات أحكام الشرع بعين النص من غير أن يعقل فيه المعنى على أن يجعل اسم النص أمارة ذلك الحكم يجوز إثبات الحكم بوصف ثابت باسم النص من غير أن يعقل فيه المعنى، على أن يكون ذلك الوصف علة للحكم، فإن للشرع ولاية شرع الاحكام كيف يشاء، ففي اشتراط كون المعنى معقولا فيما هو أمارة حكم الشرع إثبات نوع حجر لا يجوز القول به أصلا.
والفريق الثاني منهم استدلوا بمثل هذا الكلام، ولكنهم قالوا: العلة ما يتغير به حكم الحال على ما نبينه في موضعه، ووجود الحكم مع وجود الوصف قد يكون اتفاقا وقد يكون لكونه علة لا تتعين جهة كونه مغيرا إلا بانعدام الحكم عند عدمه، فبه يتبين أنه لم يكن اتفاقا.
ثم الحكم الثابت بالعلة إذا كان بحيث يحتمل الرفع لا يبقى بعد انعدام العلة، كالحكم الثابت بالبيع وهو الملك لا يبقى بعد فسخ البيع ورفعه، واشتراط قيام المنصوص عليه في الحالين ولا حكم له ليعلم به أن ثبوت الحكم بوجود علته لا بصورة النص، وذلك نحو آية الوضوء، ففي النص ذكر القيام إلى الصلاة والعلة الموجبة للطهارة الحدث، فإن الحكم يدور مع الحدث وجودا وعدما، والمنصوص عليه وهو القيام إلى الصلاة قائم في الحالين ولا حكم له، وقوله
عليه السلام: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان فيه تنصيص على الغضب، والعلة فيه شغل القلب حتى دار الحكم معه وجودا وعدما، والمنصوص عليه قائم في الحالين ولا حكم له، وقال عليه السلام: الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، ثم العلة الموجبة للحرمة والفساد الفضل على الكيل،
لان الحكم يدور معه وجودا وعدما، والمنصوص عليه وهو (الحنطة بالحنطة) قائم في الحالين ولا حكم له.
وجواب أهل الفقه عن هذه الكلمات ظاهر، فإن الظواهر الدالة على جواز العمل بالقياس بالاتفاق لا تدل على أن كل وصف من أوصاف الاصل صالح لان يكون علة، فإنه لو كان كذلك لتحير المعلل وارتفع معنى الابتلاء بطلب الحكم في الحوادث أصلا، وإذا اتفقنا على أن دلالة هذه النصوص لوصف من بين أوصاف الاصل قد ابتلينا بطلبه حين أمرنا بالاعتبار، فلا بد من أن يكون في ذلك الوصف معنى معقول يمكن التمييز به بينه وبين سائر الاوصاف ليوقف عليه، وما هذا إلا نظير النصوص المثبتة لصفة الشهادة لهذه الامة، فإن ذلك لا يمنع القول باختصاص الصلاحية ببعض الاوصاف واختصاص الاداء بلفظ الشهادة من بين سائر الالفاظ، وهذا لان أوصاف النص تعلم بالحس أو السماع وذلك يشترك فيه أهل اللغة وغيرهم ممن له حاسة صحيحة مع الفقهاء، ثم التعليل بالقياس لاثبات الحكم قد اختص به الفقهاء، فعرفنا أن اختصاصهم بذلك لم يكن إلا لمعنى معقول في الوصف الذي هو علة لا يمكن الوقوف عليه إلا بالتأمل من طريق الفقه.
وقوله علل الشرع أمارات.
قلنا: هي أمارات من حيث إنها غير موجبة بذواتها ولكنها موجبة للحكم بجعل الشرع إياها موجبة العمل بها، ومعلوم أنه لا يمكن العمل
بها إلا بعد معرفة عينها، وطريق ذلك التعيين بالنص أو الاستنباط بالرأي، وقد انعدم التعيين بالنص ولا يتأتى فيه الاستنباط بالرأي إذا لم يكن الحكم معقول المعنى، لان العقل طريق يدرك به ما يعقل كما أن الحس طريق يدرك به ما يحس دون ما لا يحس، وليس هذا نظير الاحكام الثابتة بالنص غير معقول المعنى، لان النص موجب بنفسه، فإنه كلام من يثبت علم اليقين بقوله وقد حصل التعيين بالنص هناك، فكونه غير معقول المعنى لا يعجزنا عن العمل به، فأما التعليل ببعض الاوصاف فهو غير موجب بنفسه وإنما يجب العمل به بطريق أنه إعمال الرأي ليتوصل به إلى الحجة في حكم شرعي، وما لم يكن معقول المعنى لا يتأتى إعمال الرأي فيه.
ثم الدليل على أن الدوران لا يصلح أن يكون علة أن الحكم كما يدور مع العلة وجودا وعدما يدور مع الشرط وجودا وعدما، فإن من قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالعتق بهذا الكلام يدور مع الدخول وجودا وعدما، وأحد لا يقول دخول الدار علة العتق بل هو فإن قيل: الاصل دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما، فأما الشرط شرط العتق عارض لا يكون إلا بعد تعليق الحكم به نصا.
قلنا: فأين ذهب قولك إن علل الشرع أمارات، فإنه لا يفهم من ذلك اللفظ إلا أن الشرع جعلها أمارة للحكم بأن علق الحكم بها، وأي فرق بين تعليق حكم العتق من المولى بدخول الدار شرطا وبين التعليق الثابت شرعا، ثم هناك دوران الحكم بمجرده لا يدل على كونه علة فهنا كذلك، ثم هب كان الاصل هو دوران الحكم مع العلة ولكن مع هذا احتمال الدوران مع الشرط قائم وبالاحتمال لا تثبت العلة.
فأما اشتراط قيام المنصوص عليه في الحالين
ولا حكم له فقد جعل ذلك بعضهم مفسدا للقياس باعتبار ما ذكرنا أن شرط صحة التعليل هو أن يبقى الحكم في المنصوص عليه بعد التعليل على ما كان قبله، فإذا جعل التعليل على وجه لا يبقى للنص حكم بعده يكون ذلك آية فساد القياس لا دليل صحته، فأما من شرط ذلك مستدلا بما ذكرنا فالجواب عن كلامه أن هذا وهم ابتلي به لقلة تأمله، لان المقصود بالتعليل تعدية حكم النص إلى محل لا نص فيه، فكيف يجوز أن لا يبقى للنص حكم بعد التعليل ؟ وإذا لم يبق له حكم فالتعدية بعد التعليل في أي شئ يكون.
فأما آية الوضوء فنحن لا نقول إن الحدث علة لوجوب الوضوء، ولكن من شرط القيام لاداء الصلاة الطهارة عن الحدث، فكان تقدير الآية: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، ولكن سقط ذكر الحدث للايجاز والاختصار على ما هو عادة أهل اللسان في إسقاط بعض الالفاظ إيجازا إذا كان في الباقي
دليل عليه، ففي المذكور هنا دليل على المحذوف وهو قوله تعالى: (ولكن يريد ليطهركم) .
(وإن كنتم جنبا فاطهروا) وقوله تعالى عند ذكر البدل: (أو جاء أحد منكم من الغائط) وقد علم أن البدل إنما يجب عند عدم الاصل بما يجب به الاصل، فظهر أنا إنما جعلنا الحدث شرطا لوجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة بدلالة النص لا بطريق التعليل والاستنباط بالرأي.
وكذلك قوله عليه السلام: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان إنما عرفنا أن المراد النهي عن القضاء عند شغل القلب لمخافة الغلط بدليل الاجماع لا بطريق الاستنباط بالرأي، والاجماع حجة سوى الرأي، فإن التعليل بالرأي يكون بعد الاجماع بالاتفاق، وكيف يستقيم أن لا يكون للنص حكم بعد التعليل والشرع ما جعل التعليل بالرأي إلا بعد النص
وإلا لاثبات الحكم فيما لا نص فيه.
وبيان هذا في حديث معاذ حين قال له: (كيف تقضي) وحديث نص الربا هكذا، فإن المساواة في الكيل إنما عرفناه بالنص لا بالرأي وهو قوله عليه السلام في بعض الروايات مكان قوله (مثل بمثل) (كيل بكيل) أو بالاجماع، فقد اتفقوا أنه ليس المراد من قوله (مثل بمثل) إلا المماثلة في الكيل، وكذلك (في) قوله: (إلا سواء بسواء) اتفاق أن المراد المساواة في الكيل، فعرفنا أن من قال في هذه المواضع بأن الحكم دار مع العلة وجودا وعدما والمنصوص عليه قائم في الحالين ولا حكم له، فهو مخطئ غير متأمل في مورد النص ولا فيما هو طريق التعليل في الفقه.
ثم الدليل على أن انعدام الحكم عند عدم الوصف لا يكون دليل صحة العلة ما ذكرنا من الشرط، ولان ثبوت الحكم لما كان بورود الشرع به فانعدام الحكم عند انعدام العلة الموجبة شرعا يكون بالعدم الذي هو أصل فيه لا أن يكون مضافا إلى العلة حتى
يكون دليل صحة العلة.
والدليل على أن وجود الحكم عند عدم العلة لا يكون دليل فساد العلة اتفاق الكل على أن الحكم يجوز أن يكون ثابتا في محل بعلل، ثم بانعدام بعضها لا يمتنع بقاء الحكم بالبعض الذي هو باق، كما لا يمتنع ثبوت الحكم ابتدا بتلك العلة، وبهذا يتبين أنه لا بد من القول بأنه لا ينعدم الحكم إلا بانعدام جميع العلل التي كان الحكم ثابتا بكل واحد منها، فعرفنا أن وجود الحكم عند عدم العلة لا يكون دليل فسادها، وفساد القول بأن دليل صحة العلة دوران الحكم معه وجودا وعدما كالمتفق عليه، فإن القائسين اتفقوا أن علة الربا أحد أوصاف الاصل، وادعى كل واحد منهم أن الصحيح ما ذهب إليه، ومعلوم أن كل قائل
يمكنه أن يستدل على صحة علته بدوران الحكم معه وجودا وعدما.
وكذلك لو قال إن العلة في تكفير المستحل للخمر معنى الشدة والمرارة كان ذلك فاسدا بالاتفاق، فإن أحدا لا يقول بتكفير مستحل سائر الاشربة مع وجود الشدة والمرارة.
ثم هذا القائل يتمكن من تصحيح قوله بدوران الحكم معه وجودا وعدما، فإن العصير قبل أن يتخمر لا يكفر مستحله، وبعد التخمر يكفر مستحله لوجود الشدة والمرارة، ثم بعد التحلل لا يكفر مستحله لانعدام الشدة والمرارة، إلا أن يقول بتخصيصه وقد قامت الدلالة على فساد القول بتخصيص العلل الشرعية على ما نبينه إن شاء الله تعالى، فيفسد به أيضا القول بتخصيص ما هو دليل صحة العلة، لان ذلك حجة شرعية ثابتة بطريق الرأي.
فإن قيل: مثل هذا يلزم القائلين بأن دليل صحة العلة الاثر، فإن الحكم يدور مع العلة المأثورة وجودا وعدما عند من لا يجوز تخصيص العلة وهو الصحيح.
قلنا: نعم ولكن لا نجعل الدوران دليل صحة العلة، وإنما نجعل كونه مؤثرا في الاصول دليل صحة العلة ولا يتحقق معنى دوران الحكم مع هذا الاثر في جميع الاصول، فأما دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما يكون اتفاقا.
فأما الذين قالوا من أصحاب الشافعي: بأن الاثر الذي هو دليل صحة
العلة أن يكون مخيلا، حجتهم أن هذا الاثر مما لا يحس بطريق الحس ولكنه يعقل فيكون طريق الوقوف عليه تحكيم القلب، حتى إذا تخايل في القلب به أثر القبول والصحة كان ذلك حجة للعمل به، بمنزلة التحري في باب القبلة عند انقطاع سائر الادلة، فإن تحكيم القلب فيه جائز ويجب
العمل بما يقع في قلب من ابتلي به من أنه جهة الكعبة، وعليه دل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد رضي الله عنه: ضع يدك على صدرك واستفت قلبك، فما حك في صدرك فدعه وإن أفتاك الناس به فعرفنا أن العدالة تحصل بصفة الا خالة ثم العرض على الاصول بعد ذلك احتياط والعمل به قبله جائز، بمنزلة ما لو كان الشاهد معلوم العدالة عند القاضي فإن العمل بشهادته جائز له، والعرض على المزكين بعد ذلك نوع احتياط، فإن لم يعجل ورجع إلى المزكين فهو احتياط أخذ به لجواز أن يظهر له بالرجوع إليهم ما لم يكن معلوما له، قال: وهذا بخلاف شهادة الشاهد فإن بصفة الصلاحية هناك لا تثبت العدالة، لان الشاهد مبتلى بالامر والنهي، وهو أمين فيما اؤتمن من حقوق الشرع، ويتوهم منه أداء الامانة فيكون عدلا به والخيانة فلا يكون عدلا معه، وإذا لم يكن أداء الامانة منه معلوم القاضي لا يصير عدلا عنده ما لم يعرض حاله على المزكين.
فأما الوصف الذي هو علة بعدما علم صفة الصلاحية فيه تصير عدالته معلومة إذ ليس فيه توهم الخيانة، فلهذا كان العرض على الاصول هنا احتياطا، فإن سلم عما يناقضه ويعارضه بكونه مطردا في الاصول فحكم وجوب العمل به يزداد وكادة، وإن ورد عليه نقض فذلك النقض جرح، بمنزلة الشاهد الذي هو معلوم العدالة إذا ظهر فيه طعن من بعض المزكين، فإن ذلك يكون جرحا في عدالته إلا أن يتبين له أنه لم يكن عدلا، والمعارضة دفع بمنزلة شاهد آخر يشهد بخلاف ما شهد به العدل.
وأما الفريق الثاني فإنهم قالوا: كونه مخيلا أمر باطن لا يمكن إثباته
على الخصم، وما لم تثبت صفة العدالة بما يكون حجة على الخصم لا يمكن
إلزام الخصم به، وأثبتنا صفة العدالة فيه بما أثبتنا صفة الصلاحية وهو الملاءمة، فإن ذلك يكون بالعرض على العلل المنقولة عن السلف، حتى إذا علم الموافقة كان صالحا، وبعد صفة الصلاحية يحتمل أن لا يكون حجة، لان العلل الشرعية لا توجب الحكم بذواتها فلا بد من إثبات صفة العدالة فيه بالعرض على الاصول، حتى إذا كان مطردا سالما عن النقوض والمعارضات فحينئذ تثبت عدالته من قبل أن الاصول شهادة لله على أحكامه كما كان الرسول في حال حياته، فيكون العرض على الاصول وامتناع الاصول من رده بمنزلة العرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وسكوته عن الرد، وذلك دليل عدالته باعتبار أن السكوت بعد تحقق الحاجة إلى البيان لا يحل، فعرفنا أن بالعرض على الاصول تثبت العدالة، كما أن عدالة الشاهد تثبت بعرض حاله على المزكين.
والفرق الثاني الذي قالوا ليس بقوي، فإن بعد ثبوت صفة الصلاحية للشاهد إنما بقي احتمال الكذب في أدائه، وهنا بعد ثبوت صفة الصلاحية بقي الاحتمال في أصله أن الشرع جعله علة للحكم أم لا، فإنه إن ورد عليه نقض أو معارضة يتبين به أن الشرع ما جعله علة للحكم، لان المناقضة اللازمة لا تكون في الحجج الشرعية، قال الله تعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وكذلك المعارضة اللازمة لا تكون في الحجج الشرعية فإذا كان هناك مع بقاء الاحتمال في الوصف لا يكون حجة للعمل به فهنا مع بقاء الاحتمال في الاصل لان لا يكون حجة كان أولى، وكما أن طريق رفع ذلك الاحتمال هناك العرض على المزكين والادنى فيه اثنان، فالطريق هنا العرض على الاصول وأدنى ذلك أصلان، إذ لا نهاية للاعلى، وفي الوقوف على ذلك حرج بين، وبهذا التقرير يتبين أن العرض على جميع الاصول ليس بشرط عنده، كما ذهب إليه بعض
شيوخنا وشيوخه، فإن من شرط ذلك لم يجد بدا من العمل بلا دليل،
لانه وإن استقصى في العرض فالخصم يقول وراء هذا أصل آخر (هو) معارض أو ناقض لما يدعيه، فلا يجد بدا من أن يقول لم يقم عندي دليل النقض والمعارضة، ومثل هذا لا يصلح حجة لالزام الخصم على ما نبينه في بابه، قالوا: والذي يحقق ما ذكرنا أن المعجزة التي أوجبت علم اليقين كان طريق ثبوتها السلامة عن النقوض والمعارضات، كما قال تعالى: (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله) قال تعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فبهذا يتبين أن طريق إثبات الحجة لما لا نحس هذا.
وأما علماؤنا إنهم يقولون: حاجتنا إلى إثبات دليل الحجة فيما لا يحس ولا يعاين، وطريق ذلك أثره الذي ظهر في موضع من المواضع، ألا ترى أن الطريق في معرفة عدالة الشاهد هذا، وهو أن ينظر إلى أثر دينه في منعه عن ارتكاب ما يعتقد فيه الحرمة، فإذا ظهر أثر ذلك في سائر المواضع يترجح جانب الصدق في شهادته بطريق الاستدلال بالاثر، وهو أن الظاهر أنه ينزجر عن شهادة الزور لاعتقاده الحرمة فيه.
وكذلك الدلالة على إثبات الصانع تكون بآثار صنعته بطريق الوصف والبيان على وجه مجمع عليه، كما نبينه في موضعه.
وكذلك في المحسوسات كالجرح ونحو ذلك، فإنه يستدل عليه بأثره حسا، والاستدلال بالمحسوس لغير المحسوس يكون بالاثر أيضا، فتبين أن ما به يصير الوصف حجة بعد الصلاحية بالملاءمة على ما قرره الخصم وهو ظهور أثره في الاصول، فأما الا خالة فهو عبارة عن مجرد الظن إذ الخيال والظن واحد، والظن لا يغني من الحق شيئا.
وأحسن العبارات فيه أن يجعل
بمنزلة الالهام وهو لا يصلح للالزام على الغير، على ما نبينه، ثم هذا شئ في الباطن لا يطلع عليه غير صاحبه ومثله لا يكون حجة على الغير، كالتحري الذي استشهد به، فإن ما يؤدي إليه تحري الواحد لا يكون حجة على أصحابه، حتى لا يلزمهم اتباعه في تلك الجهة، وكلامنا فيما يكون حجة
لالزام الغير العمل به، ثم كل خصم يتمكن من أن يقول يخايل في قلبي أثر القبول والصحة للوصف الذي دعاه، بل للحكم الذي هو المقصود، وصفة التعارض لا يجوز أن يكون لازما في الحجج الشرعية كصفة المناقضة.
وكذلك الاطراد لا يستقيم أن يجعل دليل كونه حجة، لانه عبارة عن عموم شهادة هذا الوصف في الاصول فيكون نظير كثرة أداء الشهادة من الشاهدين في الحوادث عند القاضي، أو تكرار الاداء منه في حادثة واحدة وذلك لا يكون موجبا عدالته.
قوله بأن الاصول مزكون كالرسول، قلنا: لا كذلك، بل كل أصل شاهد، فالاصول كجماعة الشهود أو عدد الرواة للخبر، ودليل صحة الخبر وكونه حجة إنما يطلب من متن الحديث، فالاثر للوصف بمنزلة دليل الصحة من متن الخبر، والاطراد في الاصول بمنزلة كثرة الرواة، فكيف يستقيم أن يجعل الاصول مزكين ولا معرفة لهم بهذا الوصف وحاله، وأنى تكون التزكية ممن لا خبرة له ولا معرفة بحال الشاهد ؟ وما قالوا: إن المعجزة بمثل هذا صارت حجة فهو غلط، وإنما صارت حجة بكونها خارجة عن حد مقدور البشر، فإن القرآن بهذه الصفة، ولكن الكفار كانوا يتعنتون فيقولون إنه من جنس كلام البشر، كما أخبر الله تعالى عنهم (قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا) فطولبوا بالاتيان بمثله ليظهر به تعنتهم فإنهم
لو قدروا على ذلك ما صبروا على الامتناع عنه إلى القتال وفيه ذهاب نفوسهم وأموالهم.
فإن قيل: في اعتبار الاثر اعتبار ما لا يمكن الوقوف فيه على حد معلوم يعقل أو يظهر للخصوم.
قلنا: لا كذلك فإن الاثر فيما يحس معلوم حسا كأثر المشي على الارض، وأثر الجراحة على البدن، وأثر الاسهال في الدواء المسهل، وفيما يعقل معلوم بطريق اللغة نحو عدالة الشاهد، فإنه يعلم بأثر دينه في المنع كما بينا، وهذا الاثر الذي ادعيناه يظهر للخصم بالتأمل، فإنه عبارة عن أثر ظاهر في بعض المواضع سوى المتنازع فيه، وهو موافق
للعلل المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والسلف من الفقهاء، رضوان الله عليهم أجمعين.
فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات لانها علة مؤثرة فيما يرجع إلى التخفيف، لانه عبارة عن عموم البلوى والضرورة في سؤره، وقد ظهر تأثير الضرورة في إسقاط حكم الحرمة أصلا بالنص، وهو قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) والاشارة إليه لدفع نجاسة سؤره أو لاثبات حكم التخفيف في سؤره يكون استدلالا له بعلة مؤثرة.
وكذلك قوله عليه السلام: إنها دم عرق انفجر فإنه استدلال بعلة مؤثرة في نقض الطهارة، وهو أن الدم في نفسه نجس، وبالانفجار يصل إلى موضع يجب تطهير ذلك الموضع منه، ووجوب التطهير لا يكون إلا بعد وجود ما يعدم الطهارة.
فإن قيل: هذا ليس بتعليل منه لانتقاض الطهارة بدم الاستحاضة بل لبيان أنه ليس بدم الحيض.
قلنا: قد قال أولا ليست بالحيضة، وهذا اللفظ كاف
لهذا المقصود فلا بد من أن يحمل قوله (ولكنها دم عرق انفجر) على فائدة جديدة وليس ذلك إلا بيان علة للحدث الموجب للطهارة.
وقال عليه السلام لعمر رضي الله عنه في القبلة: أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك ؟ فهذا إشارة إلى علة مؤثرة، أي الفطر ضد الصوم، وإنما يتأدى الصوم بالكف عن اقتضاء الشهوتين، فكما أن اقتضاء شهوة البطن بما يصل إلى الحلق لا بما يصل إلى الفم حتى لا تكون المضمضة موجبة للفطر، فكذلك اقتضاء شهوة الفرج يكون بالايلاج أو الانزال لا بمجرد القبلة التي هي المقدمة.
وكذلك قوله للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين ؟ الحديث، هو إشارة إلى العلة المؤثرة وهو أن صاحب الحق يقبل من غير من عليه الحق إذا جاء بحقه فأداه على سبيل الاحسان والمساهلة مع من عليه الحق، والله هو المحسن المتفضل على عباده فهو أحق من أن يقبل منك.
وقال في حرمة الصدقة على بني هاشم: أرأيت لو تضمضت بماء أكنت شاربه ؟ ففيه إشارة إلى علة مؤثرة وهو
أن الصدقة من أوساخ الناس لكونها مطهرة من الذنوب فهي كالغسالة المستعملة، والامتناع من شرب ذلك يكون بطريق الاخذ بمعالي الامور، فكذلك حرمة الصدقة على بني هاشم يكون على وجه التعظيم والاكرام لهم ليكون لهم خصوصية بما هو من معالي الامور.
وكذلك الصحابة حين اختلفوا في الجد مع الاخوة اشتغلوا بالتعليل لاظهار صفة القرب بالوادي الذي تتشعب منه الانهار والشجرة التي ينبت منها الاغصان، وما ذلك إلا باعتبار المؤثر في العلم بتفاوت القرب بطريق محسوس، وابن عباس علل في ذلك بقوله: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الاب أبا.
فهو استدلال المؤثر من حيث اعتبار أحد الطرفين بالطرف الآخر في القرب.
وقال عمر لعبادة
بن الصامت حين قال: ما أرى النار تحل شيئا في الطلاء أليس يكون خمرا ثم يكون خلا فتشربه، فهذا استدلال بمؤثر وهو التغيير بالطباع.
وعلل محمد في كتاب الطلاق فيمن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها ثلاثا أن اليمين لا يبقى، لانه ذهب تطليقات ذلك الملك كله، وهذا تعليل بوصف مؤثر، فإن اليمين لا تنعقد إلا في الملك باعتبار تطليقات مملوكة أو مضافة إلى الملك، والاضافة إلى الملك لم توجد هنا، فعرفنا أنها انعقدت على التطليقات المملوكة، وقد أوقع كلها والكل من كل شئ لا يتصور فيه تعدد، فعرفنا أنه لم يبق شئ من الجزاء واليمين شرط وجزاء، فكما لا يتصور انعقادها بدون الجزاء لا يتصور بقاؤها إذا لم يبق شئ من الجزاء.
وقال أبو حنيفة رحمه الله فيمن اشترى قريبه مع غيره حتى عتق نصيبه منه لا يضمن لشريكه شيئا، لان شريكه رضي بالذي وقع به العتق بعينه، يعني ملك القريب الذي هو متمم لعلة العتق، وهذا تعليل بوصف مؤثر، فإن ضمان العتق إنما يجب بالافساد أو الاتلاف لملك الشريك فيكون واجبا بطريق الجبران له ورضاه بالسبب يغني عن الحاجة إلى الجبران، لان الحاجة إلى ذلك لدفع الضرر عنه وقد اندفع ذلك حكما حين رضي به كما لو أذن له نصا أن يعتقه.
وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله فيمن أودع صبيا مالا فاستهلكه
لا ضمان عليه، لانه سلطه على ما فعل، أي حين مكنه من المال، فقد سلطه على إتلافه حسا، والتسليط يخرج فعل المسلط من أن يكون جناية في حق المسلط، ثم بقوله: احفظ، جعل التسليط مقصورا على الحفظ بطريق العقد، وهذا في حق البالغ صحيح وفي حق الصبي لا يصح أصلا وفي حق العبد المحجور لا يصح في حالة الرق.
وعلل الشافعي في الزنا أنه لا يوجب حرمة المصاهرة، وقال: الزنا فعل رجمت عليه والنكاح أمر حمدت عليه، فهذا استدلال في الفرق بوصف مؤثر، أي ثبوت
حرمة المصاهرة بطريق النعمة والكرامة، فيجوز أن يكون سبب الكرامة ما يحمد المرء عليه ولا يجوز أن يكون سببه ما يعاقب المرء عليه وهو الزنا الموجب للرجم.
وقال: النكاح لا يثبت بشهادة النساء مع الرجال، لان النكاح ليس بمال.
وهذا تعليل بوصف مؤثر، يعني أن المال مبتذل وملك النكاح مصون عن الابتذال، وفي شهادة النساء مع الرجال ضرب شبهة أو هي حجة ضرورة فما يكون مبتذلا تجري المساهلة فيه وتكثر البلوى والحاجة إليه فيمكن إثباته بحجة فيها شبهة أو بما هو حجة ضرورة، فأما ما يكون مصونا عن الابتذال فإن البلوى لا تكثر فيه وهو عظيم الخطر أيضا فلا يثبت إلا بحجة أصلية خالية عن الشبهة، فعرفنا أن طريق تعليل السلف هو الاشارة إلى الوصف المؤثر، فعلى هذا النمط يكون أكثر ما عللنا به في الخلافيات.
منها أن علماءنا قالوا في أنه لا يشترط التكرار في المسح بالرأس لاكمال السنة إنه مسح فلا يسن تكراره (كالمسح بالخف والتيمم.
وقال الشافعي: هو ركن أصلي في الطهارة فيسن فيه التكرار) كالغسل في المغسولات، فكان المؤثر ما قلنا، لان في لفظ المسح ما يدل على التخفيف، فإن المسح يكون أيسر من الغسل لا محالة، وتأدى الفرض في هذا المحل بفعل المسح دليل التخفيف أيضا، وكون الاستيعاب فيه ليس بشرط بخلاف المغسولات تخفيف آخر، والاكتفاء بالمرة الواحدة لاقامة الفرض والسنة من باب التخفيف، ففي قولنا مسح إشارة إلى ما هو مؤثر فيه وليس في قوله ركن إشارة إلى ما ينفيه، ثم المقصود بالسنة
الاكمال، وفي الممسوح لما لم يكن الاستيعاب شرطا فبالمرة الواحدة مع الاستيعاب يحصل الاكمال، فعرفنا أنه يصير به مؤديا الفريضة والسنة، وفي المغسولات لما كان الاستيعاب شرطا لا يحصل بالمرة إلا إقامة الفرض فلا بد من التكرار
لاقامة السنة، وليس في قوله ركن إشارة إلى هذا الفرق، وفي قولنا مسح إشارة إليه، فكان المؤثر ما قلنا.
وقلنا في صوم الشهر بمطلق النية إنه يتأدى لانه صوم عين وهو يقول لا بد من نية الفرض لانه صوم فرض، فكان المؤثر ما قلنا، لان المقصود بالنية في الاصل التمييز ولا يراد بنية الجهة إلا التمييز بين تلك الجهة وغيرها، وإذا كان المشروع في هذا الزمان عينا ليس معه غيره، يصاب بمطلق الاسم فارتفعت الحاجة إلى الجهة للتمييز، وليس في صفة الفرضية ما ينفي هذا التعيين حتى يثبت به مساس الحاجة إلى نية الجهة للتمييز.
وقلنا في الضرورة إذا حج بنية النفل لا يقع حجة عن الفرض، لانها عبادة تتأدى بأركان معلومة بأسبابها كالصلاة، وهذا إشارة إلى وصف مؤثر وهو أن تتأدى هذه العبادة بمباشرة أركانها لا بوقتها، فصحة أداء هذه الاركان في الوقت فرضا لا ينفي صحة أدائها نفلا، وإذا بقي الاداء بصفة النفلية مشروعا من هذا الوجه فتعيينه جهة النفل بالنية صادق محله، فيجب اعتباره لا محالة بخلاف الصوم في الشهر.
وعللنا في الثيب الصغيرة أن الاب يزوجها لانها صغيرة ولا يزوج البكر البالغة إلا برضاها لانها بالغة، والخصم قال في الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها من غير رضاها لانها ثيب، وفي البكر البالغة يزوجها من غير رضاها لانها بكر فكان المؤثر ما قلنا، لان ثبوت ولاية الاستبداد بالعقد يكون على وجه النظر للمولى عليه باعتبار عجزه عن مباشرة ذلك بنفسه مع حاجته إلى مقصوده كالنفقة، والمؤثر في ذلك الصغر والبلوغ دون الثيابة والبكارة.
وكذلك في سائر المواضع إنما ظهر الاثر للصغر والبلوغ في الولاية لا للثيابة والبكارة،
يعني الولاية في المال والولاية على الذكر، فعرفنا أنا سلكنا طريق السلف،
في الاستدلال بالوصف (المؤثر).
فإن قيل: كيف يستقيم هذا والقياس لا يكون إلا بفرع وأصل، فإن المقايسة تقدير الشئ بالشئ، وبمجرد ذكر الوصف بدون الرد إلى الاصل لا يكون قياسا.
قلنا قد قال بعض مشايخنا: هذا النوع من التعليل عند ذكر الاصل يكون مقايسة وبدون ذكر الاصل يكون استدلالا بعلة مستنبطة بالرأي، بمنزلة ما قاله الخصم إن تعليل النص بعلة تتعدى إلى الفرع يكون مقايسة وبعلة لا تتعدى لا يكون مقايسة، لكن يكون بيان علة شرعية للحكم قال رضي الله عنه: والاصح عندي أن نقول: هو قياس على كل حال، فإن مثل هذا الوصف يكون له أصل في الشرع لا محالة ولكن يستغنى عن ذكره لوضوحه، وربما لا يقع الاستغناء عنه فنذكره.
فمما يقع الاستغناء عن ذكره ما قلنا في إيداع الصبي لانه سلطه على ذلك فإنه بهذا الوصف يكون مقيسا على أصل واضح وهو أن من أباح لصبي طعاما فتناوله لم يضمن، لانه بالاباحة سلطه على تناوله، وتركنا ذكر هذا الاصل لوضوحه.
ومما يذكر فيه الاصل ما قال علماؤنا في طول الحرة إنه لا يمنع نكاح الامة، لان كل نكاح يصح من العبد بإذن المولى فهو صحيح من الحر كنكاح حرة، وهذا إشارة إلى معنى مؤثر وهو أن الرق ينصف الحل الذي يبتنى عليه عقد النكاح شرعا ولا يبدله بحل آخر، فيكون الرقيق في النصف الباقي بمنزلة الحر في الكل، لانه ذلك الحل بعينه ولكن في هذا المعنى بعض الغموض فتقع الحاجة إلى ذكر الاصل.
وكذلك عللنا في جواز نكاح الامة الكتابية للمسلم قلنا كل امرأة يجوز لمسلم نكاحها إذا كانت مسلمة يجوز له نكاحها إذا كانت كتابية كالحرة، وهذا إشارة إلى معنى مؤثر وهو أن تأثير الرق في تنصيف الحل، وما يبتنى على الحل الذي في جانب المرأة غير متعدد ليتحقق معنى التنصيف في عدد،
فإن المرأة لا تحل إلا لرجل واحد فيظهر حكم التنصيف في الاحوال، وهو
أن الامة من المحللات منفردة عن الحرة، ومن المحرمات مضمومة إلى الحرة فلا يتزوجها على حرة ويتزوجها إذا لم يكن تحته حرة، ثم النصف الباقي في جانب الامة هو الثابت في حق الحرة، فإذا كان بهذا الحل يتزوج الحرة مسلمة كانت أو كتابية عرفنا أنه يتزوج الامة مسلمة كانت أو كتابية، ولكن في هذا الكلام بعض الغموض فيذكر الاصل عند التعليل، فعرفنا أن جميع ما ذكرنا استدلال بالقياس في الحقيقة وأنه موافق لطريق السلف في تعليل الاحكام الشرعية.
فصل: الحكم حكم العلة التي نسميها قياسا أو علة ثابتة بالرأي تعدية حكم النص بها إلى فرع لا نص فيه عندنا.
وعلى قول الشافعي حكمها تعلق الحكم في المنصوص بها، فأما التعدية بها جائز وليس بواجب حتى يكون التعليل بدونها صحيحا.
وإنما يتبين هذا بفصلين سبق بيانهما: أحدهما تعليل الاصل بما لا يتعدى لمنع قياس غيره عليه، عندنا لا يكون صحيحا وعنده يصح.
والثاني التعدية بالتعليل إلى محل منصوص عليه لا يصح عندنا خلافا له.
ثم حجته في هذه المسألة اعتبار العلل الشرعية بالعلل العقلية كما أن الوجود هناك يتعلق بما هو علة له، فالوجوب في العلل الشرعية يتعلق بالعلة ويكون هو الحكم المطلوب بها دون التعدية، وإنما نعني بالوجوب وجوب العمل على وجه يبقى فيه احتمال الخطأ.
واعتبر العلة المستنبطة من النص بالعلة المنصوص عليها في الشرع، فكما أن الحكم هناك يتعلق بالعلة وتكون علة صحيحة بدون التعدية فكذلك هنا، ألا ترى أن الاسباب الموجبة
للحدود والكفارات جعلت سببا شرعا ليتعلق الحكم بها بالنص من غير تعدية إلى محل آخر، فكذلك العلل الشرعية يتعلق الحكم بها في المنصوص تعدى بها إلى محل آخر أو لم يتعد.
والجواب ما هو حجتنا.
أن نقول: ما ينازعنا فيه من العلة لا يكون حجة للحكم إلا بعد النص كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: فإن لم تجده في الكتاب والسنة ؟
قال: اجتهد رأيي.
وما يكون عاملا بعد النص كان شرط عمله انعدام النص في المحل الذي يعمل فيه، فعرفنا أنه لا عمل له في محل منصوص، وإذا لم يجز أن يكون عاملا على وجه المعارضة بحكم النص بخلافه عرفنا أنه لا عمل له في موضع النص فلا يمكن أن يجعل حكمه تعلق حكم الشرع به في المنصوص، يوضحه أن بالاجماع هذه العلة لا يجوز أن يتغير بها حكم النص، ومعلوم أن التغيير دون الابطال، فإذا كان الحكم في المنصوص مضافا إلى النص قبل التعليل، فلو قلنا بالتعليل يصير مضافا إلى العلة كان إبطالا، ولا شك أنه يكون تغييرا، على معنى أن فيه إخراج سائر أوصاف النص من أن يكون الحكم مضافا إليها، وكما لا يجوز إخراج بعض المحال الذي تناوله النص من حكم النص بالتعليل لا يجوز إخراج بعض الاوصاف عن ذلك بالتعليل، يوضحه أن العلة ما يتغير بها حكم الحال، ومعلوم أن حكم النص لا يتغير بالعلة في نفسه، فعرفنا أنه يتغير بها الحال في محل آخر وهو المحل الذي تعدى إليه الحكم، فيثبت فيه بها بعد أن لم يكن ثابتا، وهذا لا يتحقق في علة لا توجب تعدية الحكم، فهذا تبين أن حكم العلة على الخصوص تعدية الحكم لا إيجاب الحكم بها ابتداء، بمنزلة الحوالة فإنها لما كانت مشتقة من التحويل كان حكمها الخاص تحول الدين الواجب بها من ذمة إلى
ذمة من غير أن تكون مؤثرة في إيجاب الدين بها ابتداء.
ومن فهم هذا سقط عنه مؤنة الحفظ في ثلاثة أرباع ما يستعمل الناس القياس فيه، لان جميع ما يتكلم الناس فيه على سبيل المقايسة أربعة أقسام: الموجب للحكم وصفته، وما هو شرط في العلة وصفته، والحكم الثابت في الشرع وصفته، والحكم المتفق على كونه مشروعا معلوما بصفته أهو مقصور على المحل الذي ورد فيه النص أم تعدى إلى غيره من المحال الذي يماثله بالتعليل.
وإنما يجوز استعمال القياس في القسم الرابع، فأما الاقسام الثلاثة فلا مدخل للقياس فيها في الاثبات ولا في النفي، لان الموجب ما جعله الشرع موجبا على ما بينا أن العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتها بل بجعل الشرع إياها موجبة، فلا مجال للرأي في معرفة ذلك وإنما طريق معرفته السماع ممن
ينزل عليه الوحي.
وصفة الشئ معتبر بأصله، وكما لا يكون موجبا بدون ركنه لا يكون موجبا بدون شرطه، ولا مدخل للرأي في معرفة شرطه ولا صفة شرطه، كما لا مدخل للرأي في أصله، وكذلك نصب الحكم ابتداء إلى الشرع، وكما ليس إلى العباد ولاية نصب الاسباب فليس إليهم ولاية نصب الاحكام، لانها مشروعة بطريق الابتلاء فأنى يهتدى بالرأي إليه، كيف يتحقق معنى الابتلاء فيما يستنبط بالرأي ابتداء، فعرفنا أن التعليل في هذه الاقسام لا يصادف محلها، والاسباب الشرعية لا تصح بدون المحل كالبيع المضاف إلى الحر والنكاح المضاف إلى محرمة، ولان حكم التعليل التعدية، ففي هذه المواضع الثلاثة لا تتحقق التعدية، فكان استعمال القياس في هذه المواضع الثلاثة بمنزلة الحوالة قبل وجوب الدين وذلك باطل لخلوه عن حكمه وهو التحويل.
وكما لا يجوز استعمال القياس لاثبات الحكم في هذه المواضع
لا يجوز للنفي، لان المنكر لذلك يدعي أنه غير مشروع وما ليس بمشروع كيف يمكن إثباته بدليل شرعي، وإن كان يدعي رفعه بعد الثبوت وهو نسخ وإثبات النسخ بالتعليل بالرأي لا يجوز، فعرفنا أن ما يصنعه بعض الناس من استعمال القياس في مثل هذه المواضع ليس بفقه وأنه يكون من قلة التأمل، يتبين ذلك عند النظر.
وأما بيان الموجب في مسائل.
منها (أن) الجنس بانفراده هل يحرم النسأ، فإن الكلام فيه بطريق القياس للاثبات أو للنفي باطل، وإنما طريق إثباته الرجوع إلى النص أو دلالته أو إشارته أو مقتضاه، لان الثابت بهذه الوجوه كالثابت بالنص والموجب للحكم لا يعرف إلا بالنص كالحكم الواجب، فإنه إذا وقع الاختلاف في الوتر هل هي بمنزلة الفريضة زيادة على الخمس كان الاشتغال بإثباته بطريق القياس خطأ، وإنما أثبت ذلك أبو حنيفة رحمه الله بالنص المروي فيه وهو قوله عليه السلام: إن الله تعالى زادكم صلاة، ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر فكذلك طريق
إثبات كون الجنس علة الرجوع إلى النص ودلالته، وهو أنه قد ثبت بالنص حرمة الفضل الخالي عن العوض إذا كان مشروطا في العقد، وباشتراط الاجل يتوهم فضل مال خال عن المقابلة باعتبار صفة الحلول في أحد الجانبين، ولم يسقط اعتباره بالنص لكونه حاصلا بصنع العباد، والشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما بني أمره على الاحتياط، فكما أن حقيقة الفضل تكون ربا فكذلك شبهة الفضل، وللجنسية أثر في إظهار ذلك، وكما أن القياس لا يكون طريقا للاثبات هنا لا يكون طريقا للنفي، لان من ينفي إنما يتمسك بالعدم الذي هو أصل، فعليه الاشتغال بإفساد دليل خصمه، لانه متى ثبت أن ما ادعاه
الخصم دليل صحيح لا يبقى له حق التمسك بعدم الدليل، فأما الاشتغال بالقياس ليثبت العدم به يكون ظاهر الفساد.
ونظيره الاختلاف في أن السفر هل يكون مسقطا شطر الصلاة فإنه لا مدخل للقياس هنا في الاثبات ولا في النفي، وإنما يعرف ذلك بالنص ودلالته وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ولا معنى للتصدق هنا سوى الاسقاط، ولا مرد لما أسقطه الله عن عباده بوجه.
وكذلك الخلاف في أن استتار القدم بالخف هل يكون مانعا من سراية الحدث إلى القدم لا مدخل للقياس فيه في النفي ولا في الاثبات، وإنما يثبت ذلك بالنص ودلالته وهو قوله عليه السلام: إني أدخلتهما وهما طاهرتان ففي هذا إشارة إلى أن الحدث ما سرى إلى القدمين لاستتارهما بالخف.
وكذلك الخلاف في أن مجرد الاسلام بدون الاحراز بالدار هل يوجب تقوم النفس والمال أم لا، وأن خبر الواحد هل يكون موجبا للعلم، وأن القياس هل يكون موجبا للعمل به ؟ هذا كله لا مدخل للتعليل بالرأي في إثباته ولا في نفيه.
وأما بيان صفته فنحو الاختلاف الواقع في النصاب أنه موجب للزكاة بصفة النماء أم بدون هذا الوصف موجب، وفي اليمين أنها موجبة للكفارة بصفة أنها مقصودة أم بصفة أنها معقودة، وفي القتل بغير حق أنه موجب
للكفارة بصفة أنه حرام أم اشتماله على الوصفين الحظر والاباحة من وجهين، وكفارة الفطر أنها واجبة بفعل موصوف بأنه جماع أو هو فطر بجناية متكاملة ؟ فإن هذا كله مما لا مدخل للرأي في إثبات الوصف المطلوب به ولا في نفيه.
وبيان الشرط فنحو اختلاف العلماء في اشتراط الشهود في النكاح للحل، واختلافهم في اشتراط التسمية في الذكاة للحل فإنه لا مدخل للرأي في معرفة
ما هو شرط في السبب شرعا لا في الاثبات ولا في النفي، كما لا مدخل له في أصل السبب بأن بالشرط يرتفع الحكم قبل وجوده، فإذا لم يكن للرأي مدخل فيما يثبته عرفنا أنه لا مدخل للرأي فيما يرفعه أو يعدمه.
وكذلك الخلاف في أن البلوغ عن عقل هل يكون شرطا لوجوب حقوق الله تعالى المالية نحو الزكوات والكفارات، ولايجاب ما هو عقوبة مالية نحو حرمان الميراث بالقتل، أو دفع الاختلاف في أن البلوغ عن عقل هل يكون شرطا لصحة الاداء فيما لا يحتمل النسخ والتبديل، فإن هذا لا مدخل للقياس فيه في الاثبات والنفي.
وكذلك في أن بلوغ الدعوة هل تكون شرطا لاهدار النفوس والاموال بسبب الكفر، فإن هذا مما لا يمكن معرفته بالقياس، والتعليل بالرأي فيه للاثبات أو النفي يكون ساقطا.
وكذلك الاختلاف في اشتراط الولي في النكاح، فأما في ثبوت الولاية للمرأة على نفسها يجوز استعمال القياس، لان المعنى الذي به تثبت الولاية للمرء على نفسه معقول وهو متفق عليه في الاصل وهو الرجل، فيستقيم تعدية الحكم به إلى المرأة.
فإن قيل: فقد اختلفنا في التقابض في المجلس أنه هل يشترط في بيع الطعام بالطعام ؟ وقد تكلمتم بالقياس، وإليه أشار محمد فقال: من قبل أنه حاضر ليس له أجل.
قلنا: لان هناك قد وجد أصل كان هذا الحكم، وهو بقاء العقد بعد الافتراق عن المجلس من غير قبض فيه ثابت بالاتفاق، وهو بيع الطعام وسائر الامتعة بالدراهم فأمكن تعليل ذلك الاصل لتعدية الحكم به إلى الفرع، والخصم وجد أصلا للحكم الذي ادعاه وهو فساد
العقد بعد الافتراق من غير قبض كما في الصرف استقام تعليله أيضا لتعدية الحكم به إلى الفرع، ومثله لا يوجد في اشتراط التسمية في الذكاة، فإن الخصم
لا يجد فيه أصلا يسقط فيه اشتراط التسمية لحل الذبيحة، فإن أصله الناسي، ونحن لا نقول هناك سقط شرط التسمية، ولكن نجعل الناسي كالمسمى حكما بدلالة النص، كما يجعل الناسي كالمباشر لركن الصوم وهو الامساك حكما بالنص، وهذا معلول عن القياس وتعليل مثله لتعدية الحكم لا يجوز.
وكذلك في النكاح فإنه لا يجد أصلا يكون فيه اتفاق على صحة النكاح وثبوت الحل به بغير شهود حتى لعلل ذلك الاصل فيتعدى الحكم فيه إلى هذا الفرع.
فإن قيل: لا كذلك، فإن النكاح عقد معاملة حتى يصح من الكافر والمسلم، وقد وجدنا أصلا في عقود المعاملات يسقط اشتراط الشهود لصحته شرعا وهو البيع وإن كان يترتب عليه حل الاستمتاع، فنعلل ذلك الاصل لتعدية الحكم به إلى الفرع.
قلنا: من حيث إن النكاح معاملة أمد لا يشترط فيه الشهود، فخصم هذا المعلل يقول بموجب علته، وإنما يدعي شرط الشهود فيه اعتبار أنه عقد مشروع للتناسل وأنه يرد على محل له خطر، وهو مصون عن الابتذال، فلاظهار خطره يختص شرط الشهود، ولا نجد أصلا في المشروعات بهذه الصفة لتعليل ذلك الاصل فيعدى الحكم به إلى الفرع.
وأما بيان صفته فنحو الاختلاف في صفة العدالة في شهود النكاح وفي صفة الذكورة، وفي صفة الموالاة والترتيب والنية في الوضوء، فإن الوضوء شرط الصلاة، فكما لا مدخل للرأي في إثبات أصل الشرط به فكذلك في إثبات الصفة فيما هو شرط.
وأما بيان الحكم فنحو الاختلاف في الركعة الواحدة، أهي صلاة مشروعة أم لا ؟ وفي القراءة المشروعة في الاخريين بالاتفاق، أهي فريضة
أم لا، وفي القراءة المفروضة في الاوليين، أتتعين الفاتحة ركنا أم لا ؟ فإنه لا مدخل للرأي في إثبات هذا الحكم، وفي المسح بالخف والمسح على الجرموق وعلى العمامة أهو جائز أم لا ؟ وأمثلة هذا في الكتب تكثر، فإن كل موضع يكون الكلام فيه في الحكم ابتداء أهو ثابت شرعا أم لا، لا مدخل للرأي في ذلك حتى يشتغل فيه بالتعليل للاثبات أو للنفي.
وأما بيان صفته فنحو الاختلاف في صفة صدقة الفطر والاضحية والوتر، والاختلاف في صفة الابانة بالطلاق عند القصد إليه من غير جعل، وفي صفة الملك الثابت بالنكاح وهو الذي يقابله البدل أهو مشترك بين الزوجين أم يختص الرجل به ؟ وفي صفة ملك النكاح أنه في حكم ملك المنفعة أو في حكم ملك العين، وفي صفة الطلاق المشروع أنه مباح بأصل الوضع أو مكروه، والاباحة صفة عارضة فيه للحاجة، وفي صفة البيع المشروع حال بقاء المتعاقدين في المجلس (أنه لازم بنفس العقد أو متراخ إلى قطع المجلس)، وفي صفة الملك الثابت بعقد الرهن أنه ملك اليد من جنس ما يثبت به حقيقة الاستيفاء أو ملك المطالبة بالبيع في الدين من جنس ما يثبت بالكفالة، وأمثلة هذه الفصول في الكتب أكثر من أن تحصى، ذكرنا من كل قسم طرفا لبيان الطريق للمتأمل فيه.
وأما بيان القسم الرابع: فنحو الاختلاف في المسح بالرأس أنه هل يسن تثليثه فإنه يوجد في الطهارة ما هو مسح ولا يكون التكرار فيه مسنونا فيمكن تعليل ذلك المتفق عليه لتعدية الحكم به إلى الفرع المختلف فيه، ويوجد في أعضاء الطهارة ما يكون التكرار فيه مسنونا بالاتفاق، فيمكن تعليل ذلك لتعدية الحكم به إلى الفرع فيكون القياس في موضعه من الجانبين، ثم الكلام بعد
ذلك يقع في الترجيح.
وكذلك إذا وقع الاختلاف في اشتراط تعيين النية في
الصوم، فإن هناك أصلا متفقا عليه يتأدى فيه الصوم بمطلق النية، وهو النفل الذي هو عين مشروعا في وقته فيمكن تعليل ذلك لتعدية الحكم به إلى الفرع، وهناك أصل في الصوم الذي هو فرض لا يتأدى إلا بتعيين النية، وهو صوم القضاء فيمكن تعليل ذلك لتعدية الحكم به إلى الفرع فيكون القياس في موضعه من الجانبين، ثم الكلام في الترجيح بعد ذلك.
فإن قيل: فقد تكلمتم بالقياس في العذر بصوم يوم النحر وكون الصوم فيه مشروعا أم لا حكم لا مدخل للرأي فيه ثم اشتغلتم بالمقايسة فيه.
قلنا: لانا وجدنا أصلا متفقا عليه في كون الصوم مشروعا فيه وهو سائر الايام فأمكن تعدية الحكم بتعليله إلى الفرع، ثم يبقى وراء ذلك الكلام في أن النهي الذي جاء لمعنى في صفة هذا اليوم وهو أنه يوم عيد عمله يكون في إفساد المشروع مع بقائه في الاصل مشروعا أو في رفع المشروع وانتساخه، وهذا لا نثبته بالرأي وإنما نثبته بدليل النص، وهو الرجوع إلى موجب النهي أنه الانتهاء على وجه يبقى للمنتهي اختيار فيه كما قررنا.
وقد تبين بما ذكرنا أن المجيب متى اشتغل بالتعليل بالرأي فالذي يحق على السائل أن ينظر أولا أن المتنازع فيه هل هو محل له وأن ما نذكره من العلة هل يتعدى الحكم به إلى الفرع، فإن لم يكن بهذه الصفة لا يشتغل بالاعتراض على علته ولكن يتبين له بطريق الفقه أن هذا التعليل في غير موضعه، وأنه مما لا يصلح أن يكون حجة حتى يتحول المجيب إلى شئ آخر أو يبين بطريق الفقه أنه تعليل صحيح في محله موافق لطريق السلف في تعليلاتهم ليكون ما يجري بعد ذلك بينهما على طريق الفقه.
فصل: في بيان القياس والاستحسان
قال رضي الله عنه: اعلم بأن القسم الرابع الذي بيناه في الفصل المتقدم يشتمل على هذين الوجهين، وهو القياس والاستحسان عندنا، وقد طعن بعض الفقهاء في تصنيف له على عبارة علمائنا في الكتب: إلا أنا تركنا القياس واستحسنا، وقال: القائلون بالاستحسان يتركون العمل بالقياس الذي هو حجة شرعية
ويزعمون أنهم يستحسنون ذلك، وكيف يستحسن ترك الحجة والعمل بما ليس بحجة لاتباع هوى أو شهوة نفس ؟ فإن كانوا يريدون ترك القياس الذي هو حجة فالحجة الشرعية هو حق وماذا بعد الحق إلا الضلال، وإن كانوا يريدون ترك القياس الباطل شرعا فالباطل مما لا يشتغل بذكره.
وقد ذكروا في كتبهم في بعض المواضع أنا نأخذ بالقياس، فإن كان المراد هذا فكيف يجوزون الاخذ بالباطل.
وذكر من هذا الجنس ما يكون دليل قلة الحياء وقلة الورع وكثرة التهور لقائله.
فنقول وبالله التوفيق: الاستحسان لغة: وجود الشئ حسنا، يقول الرجل: استحسنت كذا: أي اعتقدته حسنا على ضد الاستقباح، أو معناه: طلب الاحسن للاتباع الذي هو مأمور به، كما قال تعالى: (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وهو في لسان الفقهاء نوعان: العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولا إلى آرائنا نحو المتعة المذكورة في قوله تعالى: (متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) أوجب ذلك بحسب اليسار والعسرة وشرط أن يكون بالمعروف، فعرفنا أن المراد ما يعرف استحسانه بغالب الرأي.
وكذلك قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ولا يظن بأحد من الفقهاء أنه يخالف هذا النوع من الاستحسان.
والنوع الآخر هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الاوهام قبل
إنعام التأمل فيه، وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من الاصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة، فإن العمل به هو الواجب، فسموا ذلك استحسانا للتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاهر الذي تسبق إليه الاوهام قبل التأمل على معنى أنه يمال بالحكم عن ذلك الظاهر لكونه مستحسنا لقوة دليله، وهو نظير عبارات أهل الصناعات في التمييز بين الطرق لمعرفة المراد، فإن أهل النحو يقولون: هذا نصب على التفسير، وهذا نصب على المصدر، وهذا نصب على الظرف، وهذا نصب على التعجب،
وما وضعوا هذه العبارات إلا للتمييز بين الادوات الناصبة.
وأهل العروض يقولون: هذا من البحر الطويل، وهذا من البحر المتقارب، وهذا من البحر المديد، فكذلك استعمال علمائنا عبارة القياس والاستحسان للتمييز بين الدليلين المتعارضين، وتخصيص أحدهما بالاستحسان لكون العمل به مستحسنا، ولكونه مائلا عن سنن القياس الظاهر، فكان هذا الاسم مستعارا لوجود معنى الاسم فيه، بمنزلة الصلاة فإنها اسم للدعاء ثم أطلقت على العبادة المشتملة على الاركان من الافعال والاقوال لما فيها من الدعاء عادة.
ثم استحسان العمل بأقوى الدليلين لا يكون من اتباع الهوى وشهوة النفس في شئ.
وقد قال الشافعي في نظائر هذا: أستحب ذلك.
وأي فرق بين من يقول أستحسن كذا، وبين من يقول أستحبه ؟ بل الاستحسان أفصح اللغتين، وأقرب إلى موافقة عبارة الشرع في هذا المراد.
وظن بعض المتأخرين من أصحابنا أن العمل بالاستحسان أولى مع جواز العمل بالقياس في موضع الاستحسان، وشبه ذلك بالطرد مع المؤثر، فإن العمل بالمؤثر أولى وإن كان العمل بالطرد جائزا.
قال رضي الله عنه:
وهذا وهم عندي فإن اللفظ المذكور في الكتب في أكثر المسائل: إلا أنا تركنا هذا القياس، والمتروك لا يجوز العمل به، وتارة يقول إلا أني أستقبح ذلك، وما يجوز العمل به من الدليل شرعا فاستقباحه يكون كفرا، فعرفنا أن الصحيح ترك القياس أصلا في الموضع الذي نأخذ بالاستحسان، وبه يتبين أن العمل بالاستحسان لا يكون مع قيام المعارضة ولكن باعتبار سقوط الاضعف بالاقوى أصلا.
وقد قال في كتاب السرقة: إذا دخل جماعة البيت وجمعوا المتاع فحملوه على ظهر أحدهم فأخرجه وخرجوا معه: في القياس القطع على الحمال خاصة، وفي الاستحسان يقطعون جميعا.
وقال في كتاب الحدود: إذا اختلف شهود الزنا في والزاويتين في بيت واحد: في القياس لا يحد المشهود عليه، وفي الاستحسان يقام الحد.
ومعلوم أن الحد يسقط بالشبهة وأدنى درجات المعارض ايراث الشبهة، فكيف يستحسن إقامة الحد في موضع الشبهة.
وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله:
تصحح ردة الصبي استحسانا.
ومعلوم أن عند قيام دليل المعارضة يرجح الموجب للاسلام وإن كان هو أضعف كالمولود بين كافر ومسلمة، وكيف يستحسن الحكم بالردة مع بقاء دليل موجب الاسلام، فعرفنا أن القياس متروك أصلا في الموضع الذي يعمل فيه بالاستحسان، وإنما سميناهما تعارض الدليلين باعتبار أصل الوضع في كل واحد من النوعين، لا أن بينهما معارضة في موضع واحد.
والدليل على أن المراد هذا ما قال في كتاب الطلاق: إذا قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق فقالت: قد حضت فكذبها الزوج فإنها لا تصدق في القياس باعتبار الظاهر وهو أن الحيض شرط الطلاق كدخولها الدار وكلامها زيدا، وفي الاستحسان تطلق، لان الحيض شئ
في باطنها لا يقف عليه غيرها فلا بد من قبول قولها فيه بمنزلة المحبة والبغض.
قال: وقد يدخل في هذا الاستحسان بعض القياس يعني به أن في سائر الاحكام المتعلقة بالحيض قبلنا قولها نحو حرمة الوطئ وانقضاء العدة، فاعتبار هذا الحكم بسائر الاحكام نوع قياس، ثم ترك القياس الاول أصلا لقوة دليل الاستحسان، وهو أنها مأمورة بالاخبار عما في رحمها منهية عن الكتمان، قال تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) ومن ضرورة النهي عن الكتمان كونها أمينة في الاظهار، وإليه أشار أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: من الامانة أن تؤتمن المرأة على ما في رحمها.
فصار ذلك القياس متروكا باعتراض هذا الدليل القوي الموجب للعمل به.
فالحاصل: أن ترك القياس يكون بالنص تارة، وبالاجماع أخرى، وبالضرورة أخرى.
فأما تركه بالنص فهو فيما أشار إليه أبو حنيفة رحمه الله في أكل الناسي للصوم: لولا قول الناس لقلت يقضي.
يعني به رواية الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو نص يجب العمل به بعد ثبوته واعتقاد البطلان في كل قياس يخالفه.
وهذا اللفظ نظير ما قال عمر رضي الله عنه في قصة الجنين: لقد كدنا أن نعمل برأينا فيما فيه أثر.
وكذلك القياس يأبى جواز السلم باعتبار أن المعقود عليه معدوم عند العقد، تركناه بالنص وهو الرخصة الثابتة بقوله عليه السلام: (ورخص في السلم) وأما ترك القياس بدليل الاجماع فنحو الاستصناع فيما فيه للناس تعامل، فإن القياس يأبى جوازه، تركنا القياس للاجماع على التعامل به فيما بين الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا (وهذا) لان القياس فيه
احتمال الخطأ والغلط، فبالنص أو الاجماع يتعين فيه جهة الخطأ فيه، فيكون واجب الترك لا جائز العمل به في الموضع الذي تعين جهة الخطأ فيه.
وأما الترك لاجل الضرورة فنحو الحكم بطهارة الآبار والحياض بعدما نجست، والحكم بطهارة الثوب النجس إذا غسل في الاجانات، فإن القياس يأبى جوازه، لان ما يرد عليه النجاسة يتنجس بملاقاته، تركناه للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس، فإن الحرج مدفوع بالنص، وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ فيه بالقياس فكان متروكا بالنص.
وكذلك جواز عقد الاجارة فإنه ثابت بخلاف القياس لحاجة الناس إلى ذلك، فإن العقد على المنافع بعد وجودها لا يتحقق لانها لا تبقى زمانين فلا بد من إقامة العين المنتفع بها مقام الاجارة في حكم جواز العقد لحاجة الناس إلى ذلك.
ثم كل واحد منهما نوعان في الحاصل: فأحد نوعي القياس ما ضعف أثره وهو ظاهر جلي، والنوع الآخر منه ما ظهر فساده واستتر وجه صحته وأثره.
وأحد نوعي الاستحسان ما قوي أثره وإن كان خفيا، والثاني ما ظهر أثره وخفي وجه الفساد فيه.
وإنما يكون الترجيح بقوة الاثر لا بالظهور ولا بالخفاء، لما بينا أن العلة الموجبة للعمل بها شرعا ما تكون مؤثرة، وضعيف الاثر يكون ساقطا في مقابلة قوي الاثر ظاهرا كان أو خفيا، بمنزلة الدنيا مع العقبى.
فالدنيا ظاهرة والعقبى باطنة، ثم ترجح العقبى حتى وجب الاشتغال بطلبها والاعراض عن طلب الدنيا لقوة الاثر من حيث البقاء
والخلود والصفاء، فكذلك القلب مع النفس والعقل مع البصر.
وبيان ما يسقط اعتباره من القياس لقوة الاثر الاستحسان الذي هو القياس المستحسن في سؤر سباع الطير، فالقياس فيه النجاسة اعتبارا بسؤر سباع الوحش بعلة
حرمة التناول، وفي الاستحسان لا يكون نجسا لان السباع غير محرم الانتفاع بها، فعرفنا أن عينها ليست بنجسة، وإنما كانت نجاسة سؤر سباع الوحش باعتبار حرمة الاكل، لانها تشرب بلسانها وهو رطب من لعابها ولعابها يتجلب من لحمها، وهذا لا يوجد في سباع الطير، لانها تأخذ الماء بمنقارها ثم تبتلعه ومنقارها عظم جاف، والعظم لا يكون نجسا من الميت فكيف يكون نجسا من الحي.
ثم تأيد هذا بالعلة المنصوص عليها في الهرة، فإن معنى البلوى يتحقق في سؤر سباع الطير، لانها تنقض من الهواء ولا يمكن صون الاواني عنها خصوصا في الصحارى، وبهذا يتبين أن من ادعى أن القول بالاستحسان قول بتخصيص العلة فقد أخطأ، لان بما ذكرنا تبين أن المعنى الموجب لنجاسة سؤر سباع الوحش الرطوبة النجسة في الآلة التي تشرب بها وقد انعدم ذلك في سباع الطير فانعدم الحكم لانعدام العلة وذلك لا يكون من تخصيص العلة في شئ، وعلى اعتبار الصورة يتراءى ذلك ولكن يتبين عند التأمل انعدام العلة أيضا، لان العلة وجوب التحرز عن الرطوبة النجسة التي يمكن التحرز عنها من غير حرج، وقد صار هذا معلوما بالتنصيص على هذا التعليل في الهرة ففي كل موضع ينعدم بعض أوصاف العلة كان انعدام الحكم لانعدام العلة فلا يكون تخصيصا وبيان الاستحسان الذي يظهر أثره ويخفى فساده مع القياس الذي يستتر أثره ويكون قويا في نفسه حتى يؤخذ فيه بالقياس ويترك الاستحسان فيما يقول في كتاب الصلاة: إذا قرأ المصلي سورة في آخرها سجدة فركع بها في القياس تجزيه، وفي الاستحسان لا تجزيه عن السجود، وبالقياس نأخذ، فوجه الاستحسان أن الركوع غير السجود وضعا، ألا ترى أن الركوع في الصلاة
لا ينوب عن سجود الصلاة فلا ينوب عن سجدة التلاوة بطريق الاولى، لان القرب بين ركوع الصلاة وسجودها أظهر من حيث إن كل واحد منهما موجب التحريمة، ولو تلا خارج الصلاة فركع لها لم يجز عن السجدة ففي الصلاة أولى، لان الركوع هنا مستحق لجهة أخرى وهناك لا، وفي القياس قال: الركوع والسجود يتشابهان، قال تعالى: (وخر راكعا) : أي ساجدا، ولكن هذا من حيث الظاهر مجاز محض، ووجه الاستحسان من حيث الظاهر اعتبار شبه صحيح ولكن قوة الاثر للقياس مستتر ووجه الفساد في الاستحسان خفي.
وبيان ذلك أنه ليس المقصود من السجدة عند التلاوة عين السجدة، ولهذا لا تكون السجدة الواحدة قربة مقصودة بنفسها حتى لا تلزم بالنذر إنما المقصود إظهار التواضع وإظهار المخالفة للذين امتنعوا من السجود استكبارا منهم، كما أخبر الله عنهم في مواضع السجدة.
قلنا: ومعنى التواضع يحصل بالركوع ولكن شرطه أن يكون بطريق هو عبادة وهذا يوجد في الصلاة، لان الركوع فيها عبادة كالسجود ولا يوجد خارج الصلاة، ولقوة الاثر من هذا الوجه أخذنا بالقياس وإن كان مستترا وسقط اعتبار الجانب الآخر في مقابلته.
وكذلك قال في البيوع: إذا وقع الاختلاف بين المسلم إليه ورب السلم في ذرعان المسلم فيه في القياس يتحالفان، وبالقياس نأخذ، وفي الاستحسان القول قول المسلم إليه.
ووجه الاستحسان أن المسلم فيه مبيع فالاختلاف في ذرعانه لا يكون اختلافا في أصله بل في صفته من حيث الطول والسعة، وذلك لا يوجب التحالف كالاختلاف في ذرعان الثوب المبيع بعينه.
ووجه القياس أنهما اختلفا في المستحق بعقد السلم وذلك يوجب التحالف، ثم أثر القياس مستتر ولكنه قوي من حيث إن عند
السلم إنما يعقد بالاوصاف المذكورة لا بالاشارة إلى العين، فكان الموصوف بأنه خمس في سبع غير الموصوف بأنه أربع في ستة، فبهذا يتبين أن الاختلاف
هنا في أصل المستحق بالعقد فأخذنا بالقياس لهذا.
وقال في الرهن: إذا ادعى رجلان كل واحد منهما عينا في يد رجل أنه مرهون عنده بدين له عليه وأقاما البينة، ففي الاستحسان يقضي بأنه مرهون عندهما، بمنزلة ما لو رهن عينا من رجلين، وهو قياس البيع في ذلك، وفي القياس تبطل البينتان، لانه تعذر القضاء بالرهن لكل واحد منهما في جميعه فإن المحل يضيق عن ذلك، وفي نصفه لان الشيوع يمنع صحة الرهن، وأخذنا بالقياس لقوة أثره المستتر، وهو أن كل واحد منهما هنا إنما يثبت الحق لنفسه بتسمية على حدة، وكل واحد منهما غير راض بمزاحمة الآخر معه في ملك اليد المستفاد بعقد الرهن، بخلاف الرهن من رجلين فهناك العقد واحد فيمكن إثبات موجب العقد به متحدا في المحل وذلك لا يمكن هنا، وهذا النوع يعز وجوده في الكتب لا يوجد إلا قليلا، فأما النوع المتقدم فهو في الكتب أكثر من أن يحصى.
ثم فرق ما بين الاستحسان الذي يكون بالنص أو الاجماع، وبين ما يكون بالقياس الخفي المستحسن أن حكم هذا النوع يتعدى وحكم النوع الآخر لا يتعدى، لما بينا أن حكم القياس الشرعي التعدية، فهذا الخفي وإن اختص باسم الاستحسان لمعنى فهو لا يخرج من أن يكون قياسا شرعيا فيكون حكمه التعدية، والاول معدول به عن القياس بالنص وهو لا يحتمل التعدية كما بينا.
وبيانه فيما إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن والمبيع غير مقبوض، في القياس القول قول المشتري، لان البائع يدعي عليه زيادة في حقه وهو
الثمن، والمشتري منكر واليمين بالشرع في جانب المنكر، والمشتري لا يدعي على البائع شيئا في الظاهر إذ المبيع صار مملوكا له بالعقد، ولكن في الاستحسان يتخالفان، لان المشتري يدعي على البائع وجوب تسليم المبيع إليه عند إحضار أقل الثمنين والبائع منكر لذلك، والبيع كما يوجب استحقاق الملك على البائع
يوجب استحقاق اليد عليه عند وصول الثمن إليه، ثم هذا الاستحسان لكونه قياسا خفيا يتعدى حكمه إلى الاجازة وإلى النكاح في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وإلى ما لو وقع الاختلاف بين الورثة بعد موت المتبايعين، وإلى ما بعد هلاك السلعة إذا أخلف بدلا بأن قتل العبد المبيع قبل القبض ولو كان الاختلاف في الثمن بينهما بعد قبض المبيع، فإن حكم التخالف عند قيام السلعة فيه يثبت بالنص بخلاف القياس فلا يحتمل التعدية، حتى إذا كان بعد هلاك السلعة لا يجري التخالف سواء أخلف بدلا أو لم يخلف.
وفي الاجازة بعد استيفاء المعقود عليه لا يجري التخالف، وإن كان الاختلاف بين الورثة بعد قبض السلعة لا يجري التخالف.
وقد يكون القياس الذي في مقابلة الاستحسان الذي قلنا أصله مستحسن ثابت بالاثر نحو ما قال في الصلاة: وإذا نام في صلاته فاحتلم: في القياس يغتسل ويبني كما إذا سبقه الحدث، وذلك مستحسن بالاثر، وفي الاستحسان لا يبني.
وفي هذا النوع المأخوذ به هو الاستحسان على كل حال، لانه في الحقيقة رجوع إلى القياس الاصلي ببيان يظهر به أن هذا ليس في معنى المعدول به من القياس الاصلي بالاثر من كل وجه، فلو ثبت الحكم فيه كان بطريق التعدية، والمعدول به عن القياس بالاثر لا يحتمل التعدية، وذلك البيان أن الحدث الصغرى لا يحوجه إلى كشف العورة ولا إلى عمل كثير، وتكثر البلوى فيه من الصلاة،
بخلاف الحدث الكبرى، فإذا لم يكن في معناه من كل ما له كان إثبات الحكم فيه بطريق التعدية لا بالنص بعينه وذلك لا وجه له.
فتبين بجميع ما ذكرنا أن القول بالاستحسان لا يكون تخصيص العلة في شئ، ولكن في اختبار هذة العبارة اتباع الكتاب والسنة والعلماء من السلف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وكثيرا ما كان يستعمل ابن مسعود هذه العبارة، ومالك بن أنس في كتابه ذكر لفظ الاستحسان في مواضع.
وقال الشافعي رحمه الله: أستحسن في المتعة ثلاثين درهما.
فعرفنا أنه لا طعن في هذه العبارة، ومن حيث المعنى
هو قول بانعدام الحكم عند انعدام العلة، وأحد لا يخالف هذا، فإنا إذا جوزنا دخول الحمام بأجر بطريق الاستحسان فإنما تركنا القول بالفساد الذي يوجبه القياس لانعدام علة الفساد، وهو أن فساد العقد بسبب جهالة المعقود عليه ليس لعين الجهالة بل لانها تفضي إلى منازعة مانعة عن التسليم، والتسلم وهذا لا يوجد هنا وفي نظائره، فكان انعدام الحكم لانعدام العلة لا أن يكون بطريق تخصيص العلة.
فصل: في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعية قال رضي الله عنه: زعم أهل الطرد أن الذي يقولون بالعلل المؤثرة ويجعلون التأثير مصححا للعلل الشرعية لا يجدون بدا من القول بتخصيص العلل الشرعية، وهو غلط عظيم كما نبينه.
وزعم بعض أصحابنا أن التخصيص في العلل الشرعية جائز وأنه غير مخالف لطريق السلف ولا لمذهب أهل السنة، وذلك خطأ عظيم من قائله، فإن مذهب من هو مرضي من سلفنا أنه لا يجوز التخصيص في العلل الشرعية، ومن جوز ذلك فهو مخالف لاهل السنة،
مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم.
وصورة التخصيص أن المعلل إذا أورد عليه فصل يكون الجواب فيه بخلاف ما يروم إثباته بعلته، يقول موجب علتي كذا إلا أنه ظهر مانع فصار مخصوصا باعتبار ذلك المانع، بمنزلة العام الذي يخص منه بعض ما يتناوله بالدليل الموجب للتخصيص.
ثم من جوز ذلك قال: التخصيص غير المناقضة لغة وشرعا وفقها وإجماعا.
أما اللغة فلان النقض إبطال فعل قد سبق بفعل نشأه كنقض البنيان.
والتخصيص بيان أن المخصوص لم يدخل في الجملة فكيف يكون نقضا ؟ ألا ترى أن ضد النقض البناء والتأليف، وضد الخصوص العموم.
ومن حيث السنة التخصيص جائز في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والتناقض لا يجوز فيهما بحال.
ومن حيث الاجماع فالقياس الشرعي يترك العمل به في بعض المواضع بالنص أو الاجماع أو الضرورة، وذلك يكون تخصيصا لا مناقضة، ولهذا بقي ذلك القياس موجبا للعمل في غير ذلك الموضع،
والقياس المنتقض فاسد لا يجوز العمل به في موضع.
ومن حيث المعقول إن المعلل متى ذكر وصفا صالحا وادعى أن الحكم متعلق بذلك الوصف فيورد عليه فصل يوجد فيه ذلك الوصف ويكون الحكم بخلافه، فإنه يحتمل أن يكون ذلك لفساد في أصل علته، ويحتمل أن يكون ذلك لمانع منع ثبوت الحكم، ألا ترى أن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب النامي، ثم يمتنع وجوب الزكاة بعد وجوده لمانع وهو انعدام حصول النماء بمضي الحول، ولم يكن ذلك دليل فساد السبب، والبيع بشرط الخيار يمنع ثبوت الملك به لمانع وهو الخيار المشروط لا لفساد أصل السبب وهو البيع.
فأما إذا قال هذا الموضع صار مخصوصا من علتي لمانع فقد ادعى شيئا محتملا فيكون مطالبا
بالحجة، فإن أبرز مانعا صالحا فقد أثبت ما ادعاه بالحجة فيكون ذلك مقبولا منه وإلا فقد سقط احتجاجه، لان المحتمل لا يكون حجة، وبه فارق المدعي التخصيص في النص، فإنه لا يطالب بإقامة الدليل على ما يدعي أنه صار مخصوصا مما استدل به من عموم الكتاب والسنة، لانه ليس فيما استدل به احتمال الفساد، فكان جهة التخصيص متعينا فيه بالاجماع، وهنا في علته احتمال الفساد، فما لم يتبين دليل الخصوص فيما ادعى أنه مخصوص من علة لا ينتفي عنه معنى الفساد، فلهذا لا يقبل منه ما لم يتبين المانع.
ثم جعل القائل الموانع خمسة أقسام: ما يمنع أصل العلة، وما يمنع تمام العلة، وما يمنع ابتداء الحكم، وما يمنع تمام الحكم، وما يمنع لزوم الحكم، وذلك يتبين كله حسا وحكما، فمن حيث الحس يتبين هذا كله في الرمي، فإن انقطاع الوتر أو انكسار فوق السهم يمنع أصل الفعل الذي هو رمي بعد تمام قصد الرامي إلى مباشرته، وإصابة السهم حائطا أو شجرة ترده عن سننه يمنع تمام العلة بالوصول إلى المرمى، ودفع المرمي إليه عن نفسه بترس يجعله أمامه يمنع ابتداء الحكم الذي يكون الرمي لاجله بعد تمام العلة بالوصول إلى المقصد وذلك الجرح والقتل، ومداواته الجراحة بعدما أصابه حتى اندمل وبرأ يمنع تمام الحكم، وإذا صار به صاحب فراش ثم تطاول حتى أمن الموت منه يمنع
لزوم الحكم، بمنزلة صاحب الفالج إذا تطاول ما به وامن الموت منه كان بمنزلة الصحيح في تصرفاته.
وفي الحكميات اضافة البيع الحر يمنع انعقاد اصل العلة، واضافة الى مال الغير يمنع انعقاد تمام العلة في حق المالك حتى يتعين جهة البطلان فيه بموته، واشتراط الخيار من المالك لنفسه في البيع يمنع ابتداء الحكم، وثبوت خيار الرؤية للمشترى يمنع الحكم حتى لا تتم
الصفقة معه، وثبوت خيار العيب يمنع لزوم الحكم حتى يتمكن من رده بعد تمام الصفقة بالنقض.
والحجة لعلمائنا في ابطال القول بتخصيص العلة الاستدلال بالكتاب، والمعقول، والبيان الذى لا يمكن انكاره.
اما الكتاب فقوله تعالى: (قل الذكرين حرم ام الانثيين، اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئونى بعلم ان كنتم صادقين) ففيه مطالبة الكفار ببيان العلة فيما ادعوا فيه الحرمة على وجه لا مدفع لهم فصاروا محجوجين به.
وذلك الوجه انهم إذا بينوا احد هذه المعاني ان الحرمة لاجله انتقض عليهم باقرار هم بالحل في الموضع الاخر مع ذلك المعنى فيه، ولو كان التخصيص في علل الاحكام الشرعية جائزا ما كانوا محجوجين، فان احدا لا يعجز من ان يقول امتنع ثبوت حكم الحرمة في ذلك الموضع لمانع، وقد كانوا عقلاء يعتقدون الحل في الموضع الاخر لشبهة أو معنى تصورهم عندهم.
وقوله تعالى: (نبئونى بعلم) اشارة الى ان المصير الى تخصيص العلل الشرعية ليس من العلم في شئ فيكون جهلا.
واما المعقول فلان العلل الشرعية حكمها التعدية كما قررنا، وبدون التعدية لا تكون صحيحة اصلا، لانها خالية عن موجبها، وإذا جاز قيام المانع في بعض المواضع الذى يتعدى الحكم إليه بهذه العلة جاز قيامه في جميع المواضع فيؤدى الى القول بانها علة صحيحة من غير ان يتعدى الحكم بها الى شئ من الفروع، وقد اثبتنا فساد هذا القول بالدليل.
ثم ان كان تعدية الحكم بها الى فرع
دليل صحتها فانعدام تعدية الحكم بها الى فرع اخر توجد فيه تلك العلة دليل فسادها، ومع مساواة دليل الصحة والفساد لا تثبت الحجة الشرعية موجبة
للعمل يقرره ان المانع الذى يدعى في الموضع المخصوص لابد ان يكون ثابتا بمثل ما ثبتت به العلة الموجبة للحكم، لانه إذا كان دونه لا يصلح دافعا له ولا مانعا لحكمه، وإذا كان مثلا له فذلك المانع يمكن تعليله بعلة توجب تعدية حكم النفى الى سائر الفروع مثل الذى علله المعلل بما اشار إليه من الوصف لاثبات الحكم فيه فتتحقق المعارضة بينهما من هذه الوجه، واى مناقصة ابين من التعارض على وجه المضادة بصفة التساوى ثم قد بينا فيما سبق ان دليل الخصوص يشبه النسخ بصيغة والاستثناء بحكمه، فانه مستقل بنفسه كدليل النسخ ولا يكون ذلك الا مقارنا معنى كالاستثناء، وواحد من هذين الوجهين لا يتحقق في العلل، فان نسخ العلة بالعلة لا يجوز والخصم يجوز ان يكون المانع علة مثل العلة التى يدعى تخصيصها، وكيف يجوز النسخ والعلة فيها احتمال الفساد لكونها مستنبطة بالراى.
فإذا ظهر ما يمنع العمل بها اصلا تتعين جهة الفساد فيها، بخلاف النص فانه لا يحتمل جهة الفساد، فالنسخ يكون بيانا لمدة العمل به.
ولهذا نوع بيان اخر، فان بالخصوص يتبين انه معمول به في بعض المحال دون البعض، وذلك انما يجوز فيما يجوز القول فيه بالنسخ مع صحته حتى يقال انه معمول به في بعض الاوقات دون البعض، والاستثناء انما يكون في العبارات ليتبين به في بعض الاوقات دون البعض، والاستثناء وذلك لا يتحقق في المعاني الخالصة.
فيتبين بما ذكرنا ان القول بالتخصيص مستقيم في النصوص من حيث ان بدليل الخصوص لا يتمكن شبهة الفساد في النص بوجه، بل يتبين ان اسم النص لم يكن متناولا للموضع المخصوص، مع كون العام صحيحا موجبا للعمل قطعا قبل قيام دليل الخصوص، فمن تخصيص العلة لا يجد بدا من القول بتصويب المجتهدين أجمع، وعصمته الاجتهاد عن احتمال الخطأ والفساد كعصمة النص من ذلك،
وهذا تصريح بأن كل مجتهد مصيب لما هو الحق حقيقة وأن الاجتهاد يوجب علم اليقين، وفيه قول بوجوب الاصلح، وفيه من وجه آخر قول بالمنزلة بين المنزلتين، وبالخلود في النار لاصحاب الكبائر إذا ماتوا قبل التوبة.
فهذا معنى قولنا: إن في القول بجواز تخصيص العلة ميلا إلى أصول المعتزلة من وجوه.
ولكنا نقول: انعدام الحكم لا يكون إلا بعد نقصان وصف أو زيادة وصف وهو الذي يسمونه مانعا مخصصا، وبهذه الزيادة والنقصان تتغير العلة لا محالة، فيصير ما هو علة الحكم منعدما حكما، وعدم الحكم عند انعدام العلة لا يكون من تخصيص العلة في شئ.
وبيان هذا أن الموجب للزكاة شرعا هو النصاب النامي الحولي، عرف بقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) والمراد نفي الوجوب، والعلل الشرعية لا توجب الحكم بذواتها بل بجعل الشرع إياها موجبة على ما بينا أن الموجب هو الله تعالى، والاضافة إلى العلة لبيان أن الشرع جعلها موجبة تيسيرا علينا، فإذا كانت بهذا الوصف موجبة شرعا عرفنا أن عند انعدام هذا الوصف ينعدم الحكم لانعدام العلة الموجبة.
ولا يلزمنا جواز الاداء لان العلة الموجبة غير العلة المجوزة للاداء، وقد قررنا هذا فيما سبق أن الجزء الاول من الوقت مجوز أداء الصلاة فرضا وإن لم يكن موجبا للاداء عينا مع أن هذا الوصف مؤثر، فإن النماء الذي هو مقصود إنما يحصل بمضي المدة، ألا ترى أن الوجوب يتكرر بتكرر الحول لتجدد معنى النماء بمضي كل حول، وكذلك البيع بشرط الخيار، فإن الموجب للملك شرعا البيع المطلق ومع شرط الخيار لا يكون مطلقا بل بهذه الزيادة يصير البيع في حق الحكم كالمتعلق بالشرط وقد بينا أن المتعلق بالشرط غير المطلق، ولصفة الاطلاق تأثير أيضا
فإن الموجب للملك بالنص التجارة عن تراض وتمام الرضا يكون عند إطلاق الايجاب لا مع شرط الخيار، فظهر أن العلة تنعدم بزيادة وصف أو نقصان
وصف، وهو الحاصل الذي يجب مراعاته، فإنهم يسمون هذا المعنى المغير مانعا مخصصا، فيقولون: انعدام الحكم مع بقاء العلة بوجود مانع وذلك تخصيص كالنص العام يلحقه خصوص فيبقى نصا فيما وراء موضع الخصوص.
ونحن نقول: تنعدم العلة حين ثبت المغير فينعدم الحكم لانعدام العلة، وهذا في العلل مستقيم، بخلاف النصوص فإن بالنص الخاص لا ينعدم النص العام، وعلى هذا الطريق ما استحسنه علماؤنا من القياس في كتبهم، فإن الاستحسان قد يكون بالنص، وبوجود النص تنعدم العلة الثابتة بالرأي، لانه لا معتبر بالعلة أصلا في موضع النص ولا في معارضة حكم النص.
وكذلك الاستحسان إذا كان بسبب الاجماع، لان الاجماع كالنص من كتاب أو سنة في كونه موجبا العلم.
وكذلك ما يكون عن ضرورة فإن موضع الضرورة مجمع عليه أو منصوص عليه ولا يعتبر بالعلة في موضع النص فكان انعدام الحكم في هذه المواضع لانعدام العلة وكذلك إذا كان الاستحسان بقياس مستحسن ظهر قوة أثره، لما بينا أن الضعيف في معارضة القوي معدوم حكما.
وبيان ما ذكرنا في أن النائم إذا صب في حلقه ماء وهو صائم لم يفسد صومه على قول زفر، لانه معذور كالناسي أو أبلغ منه، وفسد صومه عندنا لفوات ركن الصوم، والعبادة لا تتأدى بدون ركنها فيلزم على هذا الناسي.
فمن يجوز تخصيص العلة يقول: انعدم الحكم هناك لوجود مانع وهو الاثر فكان مخصوصا من هذه العلة بهذا الطريق مع بقاء العلة.
ونحن نقول: انعدم الحكم في الناسي لانعدام العلة حكما، فإن النسيان لا صنع فيه لاحد من
العباد، وقد ثبت بالنص أن الله تعالى أطعمه وسقاه، وصار فعله في الاكل ساقط الاعتبار، وتفويت الركن إنما يكون بفعل الاكل، فإذا لم يبق فعله في الاكل شرعا كان ركن الصوم قائما حكما، وإنما لم يحصل الفطر هنا لانعدام العلة الموجبة للفطر، ثم النائم ليس في معناه، لان الفعل الذي يفوت به ركن الصوم مضاف إلى العباد هنا فيبقى معتبرا مفوتا ركن
الصوم، بخلاف إذا كان مضافا الى من له الحق.
وكذلك قلنا: إن المغصوب يصير مملوكا للغاصب عند تقرر الضمان عليه، لان بهذا السبب لما تقرر الملك في ضمان القيمة وهو حكم شرعى فيقرر الملك فيما يقابله فيلزم على هذا فصل المدبر من حيث انه يتقرر الملك في قيمته للمغصوب منه ولا يثبت الملك في المدبر للغاصب، فمن يرى تخصيص العلة يقول امتنع ثبوت الحكم في المدبر مع وجود العلة لمانع وهو انه غير محتمل للنقل من ملك الى ملك.
ونحن نقول: انعدمت العلة الموجبة للملك في المدبر فينعدم الحكم لانعدام العلة، وهذا لان العلة تقرر الملك في قيمة هي بدل عن العين وقيمة المدبر ليس ببدل عن عينها، لان شرط كون القيمة بدلا عن العين ان تكون العين محتملا للتمليك وذلك لا يوجد في المدبر، لان المدبر جرى فيه عتق من وجه والعتق في المحل يمنع وجوب قيمة العين بسبب الغصب، ولكن الضمان واجب باعتبار الجناية التى تمكنت من الغاصب بتفويت يده، لان مع جريان العتق فيه من وجه قد بقيت اليد والمالية مستحقة للمالك، فان انعدام ذلك يعتمد ثبوت العتق في بقيت اليد كل وجه، فعرفنا انه انما انعدم الحكم لانعدام العلة بوجود ما يغيرها.
وكذلك إذا قلنا في الزنا انه ثبتت به حرمة المصاهرة، لان ثبوت الحرمة
في الاصل باعتبار الولد الذى يتخلق من الماءين فيصير بواسطة الولد امهاتها وبناتها في حقه كامهاته وبناته، وابناؤه وآباؤه في حقها كآبائها وابنائها.
ثم الوطء في محل الحرث سبب لحصول هذا الولد فيقام مقامه، ويلزم على هذا انه لا يتعدى الحرمة الى الاخوات والعمات والخالات من الجانبين، فمن يقول بتخصيص العلة يقول: امتنع ثبوت الحكم مع قيام العلة في هذه المواضع للنص أو الاجماع.
ونحن نقول، انما انعدم الحكم لانعدام العلة، لان في النص الموجب لحرمة المصاهرة ذكر الامهات والبنات والاباء والابناء خاصة، فامتداد الحرمة الى الاخوات والعمات والخالات يكون تغييرا
واثباتا لحرمة أخرى، لان المقصور غير الممتد، وانما يعلل المنصوص، ولا يجوز تبديل المنصوص بالتعليل، فكان انعدام الحكم في هذه المواضع لانعدام العلة لا لمانع مع قيام العلة.
وكذلك ان الزم ان الموطوءة لا تحرم على الواطئ بواسطة الولد والقرب بينهما امس، فالتخريج هكذا انه انما انعدم الحكم هناك لانعدام العلة باعتبار مورد النص كما قررنا.
وهذا اصل كبير، وفقه عظيم.
من ترك التعنت وتامل عن انصاف يخرج له جميع ما لم يذكر بما هو من نظائر ما ذكرنا عليه.
وعمدة هذا الفقه معرفته دليل الخصوص، فان النصين إذا كان احدهما عاما والاخر خاصا فالعام لا ينعدم بالخاص حقيقة ولا حكما، وليس في واحد من النصين توهم الفساد، فعرفنا ان الخاص كان مخصصا للموضع الذى تناوله من حكم العم مع بقاء العام حجة فيما وراء ذلك وان تمكن فيه نوع شبهة من حيث انه صار كالمستعار فيما هو حقيقة حكم العام.
فاما العلة وان كانت مؤثرة ففيها احتمال الفساد والخطاء وهى تحتمل الاعدام حكما،
فإذا جاء ما يغيرها جعلناها معدومة حكما في ذلك الموضع، ثم انعدم الحكم لانعدام العلة، ولا يكون فيها شئ من معنى التناقض، ولا يكون من التخصيص في شئ، والله اعلم.
باب وجوه الاحتجاج بما ليس بحجة مطلقا قال رضى الله عنه: فهذا الباب يشتمل على فصول.
فالذي نبدأ به الاحتجاج بلا دليل، فان العلماء اختلفوا فيه على أقاويل.
قال بعضهم: لا دليل حجة للنافى على خصمه ولا يكون حجة للمثبت.
وقال بعضهم: هي حجة دافعة لا موجبة.
والذى دل عليه مسائل الشافعي رحمه الله انها حجة دافعة لابقاء ما ثبت بدليله لا لاثبات ما لم يعلم ثبوته بدليله.
والذى دل عليه مسائل اصحابنا ان هذا في حق الله تعالى، فاما في حق
العباد لا تكون هي حجة لاحد الخصمين على الآخر في الدفع ولا في الايجاب لا في الابقاء ولا في الاثبات ابتداء.
فأما الفريق الاول احتجوا وقالوا: أقوى المناظرة ما يكون في إثبات التوحيد وفي أمور النبوة، فقد علمنا الله تعالى الاحتجاج بلا دليل على نفي الشرك بقوله: (ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به) ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجادل المشركين في إثبات نبوته، وكانوا ينفون ذلك وهو يثبت، ثم كانوا لا يطالبون على هذا النفي بشئ فوق قولهم لا دليل على نبوته، واشتغل بعد جحودهم بإثبات نبوته بالآيات المعجزة، والبراهين القاطعة، فعرفنا بهذا أن لا دليل حجة للنافي على خصمه إلى أن يثبت الخصم ما يدعي ثبوته بالدليل، وهذا لان النافي إنما لا يطالب بدليل لكونه متمسكا بالاصل وهو عدم الدليل الموجب أو المانع
والمحرم أو المبيح، ووجوب التمسك بالاصل إلى أن يظهر الدليل المغير له طريق في الشرع، ولهذا جعل الشرع البينة في جانب المدعي لا في جانب المنكر، لانه متمسك بالاصل وهو أنه لا حق للغير في ذمته ولا في يده وذلك حجة له على خصمه في الكف عن التعرض له ما لم يقم الدليل، وأيد ما ذكرنا قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية، فقد علم نبيه عليه السلام الاحتجاج بعدم الدليل الموجب للحرمة على الذين كانوا يثبتون الحرمة في أشياء كالسائبة والوصيلة والحام والبحيرة، فثبت بهذا أن لا دليل حجة للنافي على خصمه.
وهذا الذي ذهبوا إليه غير موافق لشئ من العلل المنقولة عن السلف في نفي الحكم وإثباته وهو ينتهي إلى الجهل أيضا، فإنا نقول لهذا القائل: لا دليل على الاثبات عندك أو عند غيرك فإن خصمك يدعي قيام الدليل عنده، وكما أن دعواه الدليل عنده لا يكون حجة عليك حتى تبرزه فدعواك عليه أن لا دليل عندي لا يكون حجة عليه، وإن قلت لا دليل عندي فهذا إقرار منك بالجهل والتقصير في الطلب، فكيف يكون حجة على غيرك ! وإن انعدم منك التقصير في الطلب فأنت معذور إذا لم تقف على الدليل وعذرك لا يكون
حجة على الغير أصلا، ألا ترى أن في زمان النبي عليه السلام كان الناسخ ينزل فيبلغ ذلك بعض الناس دون البعض ومن لم يبلغه يكون معذورا في العمل بالمنسوخ ولا يكون ذلك حجة له على غيره.
فإن قيل: قولكم هذا غير موافق لتعليل السلف فاسد، وقد قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا خمس في العنبر لان الاثر لم يرد به.
وهذا احتجاج بلا دليل.
قلنا: هذا أن لو ذكر هذا اللفظ على سبيل الاحتجاج على من يوجب فيه
الخمس وليس كذلك، بل إنما ذكره على وجه بيان العذر لنفسه ثم علل فيه بعلة مؤثرة في موضع الاحتجاج على الغير على ما ذكر محمد رحمه الله، فإنه قال: لا خمس في اللؤلؤ والعنبر.
قلت: لم ؟ قال: لانه بمنزلة السمك.
قلت: وما بال السمك لا يجب فيه الخمس ؟ قال: لانه بمنزلة الماء.
وهو إشارة إلى مؤثر، فإن الاصل في الخمس الغنائم وإنما يوجب الخمس فيما يصاب مما كان أصله في يد العدو ووقع في يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب فيكون في معنى الغنيمة، والمستخرج من البحار لم يكن في يد العدو قط، لان قهر الماء مانع قهرا آخر على ذلك الموضع، ثم القياس أن لا يجب الخمس في شئ وإنما أوجب الخمس في بعض الاموال بالاثر، فبين أن ما لم يرد فيه الاثر يؤخذ فيه بأصل القياس، وهذا لا يكون احتجاجا بلا دليل.
ثم نقول لهذا القائل: إنك بهذه المقالة تثبت شيئا لا محالة وهو صحة اعتقادك أن لا دليل يوجب إثبات الحكم في هذه الحادثة فعليك الدليل لاثبات ما تدعي صحته عندك، ولا دليل على خصمك لانه ينفي صحة اعتقادك هذا، ولا دليل على النافي بزعمك، ثم قولك لا دليل شئ تقوله عن علم أو لا عن علم ؟ فإن زعمت أنك تقوله عن علم فالعلم الذي يحدث للمرء لا يكون إلا بدليل، وإن زعمت أنك تقوله لا عن علم فقد نهيت عن ذلك، قال تعالى: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وقال تعالى: (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)
الاية، فما يكون مذموما منهيا عنه نصا فكيف يصلح حجة على الغير ! وايد ما ذكرنا قوله تعالى: (وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى، تلك امانيهم) الاية، فقد علم رسوله مطالبة النافي باقامة الدليل وذلك تنصيص على ان لا دليل لا يكون حجة والدليل عليه الخصومات،
فان انكار الخصم لا يكون حجة له على المدعى بوجه ما حتى انه بعد ما احضر مرة وجحد إذا طلب احضاره مرة اخرى احضره القاضى، وان طلب ان يكفله بنفسه أو بالعين الذى فيه الدعوى اجيره القاضى على ذلك، وإذا طلب يمينه حلفه على ذلك، فلو كان لا دليل حجة للنافى على خصمه لم يبق للمدعى عليه سبيل بعد انكاره وقوله لا حجة للمدعى.
فاما جعل الشرع القول قول المنكر فذلك باعتبار دليل من حيث الظاهر، وهو ان المدعى عين في يده واليد دليل الملك ظاهرا، أو دين في ذمته وذمته بريئة ظاهرا، ومع هذا قوله لا يكون حجة على خصمه وان حلف حتى لا يصير المدعى مقضيا عليه بشئ، ولكنه لا يتعرض له ما لم يات بحجة يثبت بها الحق عليه.
يحقق ما قلنا ان الاصل هو التفاوت بين الناس في العلم بالادلة الشرعية، واليه اشار الله تعالى في قوله: (وفوق كل ذى علم عليم) وهذا شبه المحسوس لمن يرجع الى احوال الناس، فقد يقف بعضهم على علم لا يقف عليه البعض، ومع هذا التفاوت لا يتمكن النافي من الاحتجاج بلا دليل الا بعد وقوفه على كل علم يبتنى عليه احكام الشرع، ومن ادعى هذه الدرجة لنفسه منا فهو متعنت لا يناظر، وكيف يتمكن احد من هذه الدعاوى مع قوله تعالى: (وما اوتيتم من العلم الا قليلا) وإذا علمنا يقينا ان المحتج بلا دليل لم يبلغ جميع انواع العلم عرفنا ان استدلاله بما لم يبلغه على الخصم باطل، ولهذا صح هذا النوع من الاحتجاج فيما نص الله تعالى عليه، لان الله تعالى عالم بالاشياء كلها لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا تخفى عليه خافية، فبإخباره ان لا برهان لمن يدعى الشرك حصل لنا علم اليقين بانه لا دليل على الشرك بوجه.
وكذلك قوله تعالى، (قل لا اجد فيما اوحى الى محرما) فقد صار معلوما يقينا انه لا دليل على حرمة ذلك، فكان
الاحتجاج صحيحا، ومثله لا يتصور فيما يحتج به النافي على خصمه.
ولا نقول بان نفى الكفار نبوة رسول الله وقولهم لا دليل على نبوته كان حجة لهم عليه بوجه، ولكن كان ذلك اظهارا منهم لجهلهم، وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يزيل ذلك الجهل عنهم باظهار المعجزات الدالة على نبوته.
فاما اهل المقالة الثابتة فانهم قالوا المنتفى معدوم والمعدوم ليس بشئ وانما يحتاج الى الدليل لاثبات المدلول عليه، ومعلوم ان العدم لا يكون متعلقا بدليل ولا بعدم الدليل، ولكن عدم الدليل يدل عليه كما يدل الحدث على المحدث، ثم الدليل قد يكون قائما على الاثبات عند البعض دون البعض، يقول النافي لا دليل على الاثبات محتمل يجوز ان يكون كما قال وهو انه ليس فيه دليل مشروع عند احد، ويجوز ان يكون عليه دليل عند غيره ولم يبلغه، ودعوى المثبت دليل الاثبات محتمل ايصا يجوز ان يكون صدقا بوجود الدليل عنده، ويجوز ان يكون كذبا أو غلطا فاستوى الجانبان من هذا الوجه، كما ان دعوى المثبت الدليل لا يكون حجة على خصمه ما لم يبرز الدليل لكونه محتملا والمحتمل لا فقول النافي لا دليل لا يكون حجة على خصمه لكونه محتملا ولكنه دافع لدعوى المثبت عنه بطريق المساواة في الاحتمال.
فقلنا ان قوله: لا دليل، حجة دافعة لا موجبة.
والشافعي يحتج بهذا الكلام ايضا لانه يقول: إذا كان قوله لا دليل مستندا الى دليل لا يخالف ما يقوله يكون دلك الدليل حجة على الخصم لا بمجرد قوله لا دليل.
وبيان هذا ان ما يكون محتملا للبقاء من الاحكام والصحة في العلل والجواهر فانه إذا ثبت وجوه بالدليل يكون باقيا ما لم يعترض ما يزيله، الا ترى ان الملك بالشراء متى ثبت، أو الحل بالنكاح متى ثبت،
أو الحرمة بالتطليقات الثلاث متى ثبت يكون باقيا، الا يعترض عليه
ما يزيله فما يمضي من الازمنة بعد صحة الدليل المثبت للحكم يكون الحكم فيه باقيا بذلك لدليل على احتمال أن يطرأ ما يزيله، وقبل ظهور طريان ما يزيله يكون الحكم ثابتا بذلك الدليل، بمنزلة النص العام فإنه موجب للحكم في كل ما يتناوله على احتمال قيام دليل الخصوص، فما لم يقم دليل الخصوص كان الحكم ثابتا بالعام وكان الاحتجاج به على الخصم صحيحا، فكذلك قول القائل فيما هو منتف لا دليل على إثباته، أو فيما هو ثابت بدليله لا دليل على نفيه يكون احتجاجا بذلك الدليل وذلك الدليل حجة على خصمه، فأما ما لا يستند إلى دليل فلا يبقى فيه إلا الاحتجاج بقوله لا دليل فذلك يكون حجة كما قلتم.
وعلى هذا الاصل قال: الصلح على الانكار باطل، لان نفي المنكر دعوى المدعي يستند إلى دليل وهو المعلوم من براءة ذمته في الاصل أو اليد التي هي دليل لملك له في عين المدعي، فيكون ذلك حجة له على خصمه في إبقاء ما ثبت عليه، وبعد ما ظهرت براءة ذمته في حق المدعي بهذا الدليل يكون أخذه المال رشوة على الكف عن الدعوى ولا يكون ذلك اعتياضا عن حقه فيكون باطلا، بخلاف ما إذا شهد بحرية عبد إنسان ثم اشتراه بعد ذلك فإن الشراء يكون صحيحا ويلزمه الثمن للبائع، لان نفي البائع حريته ودعواه بقاء الملك له مستند إلى دليل وهو الدليل المثبت للملك له في العبد، فيكون ذلك حجة له على خصمه في إبقاء ملكه، وباعتباره هو إنما يأخذ العوض على ملك له، وباعتباره لا يثبت الاتفاق بينهما على فساد ذلك السبب، فبهذا تعين فيه وجه الصحة ووجب الثمن على المشتري ثم يعتق عليه بعدما دخل في ملكه باعتبار زعمه.
وعلماؤنا رحمهم الله قالوا: الدليل المثبت للحكم لا يكون موجبا بقاء الحكم بوجه من الوجوه ولكن بقاؤه بعد الوجود لاستغناء البقاء عن دليل لا لوجود الدليل المنفي.
فعرفنا أنه ليس للدليل الذي استند إليه الحكم عمل في البقاء أصلا، وأن دعوى البقاء فيما عرف ثبوته بدليله محتمل كدعوى
الاثبات فيما لا يعلم ثبوته بدليله، فكما أن هناك يستوي المثبت والنافي في أن قول كل واحد منهما لا يكون حجة على خصمه بغير دليل فكذلك هنا، وله فارق العام فإنه موجب للحكم في كل ما تناوله قطعا على احتمال قيام دليل الخصوص، فما لم يظهر دليل الخصوص كان الحكم ثابتا بنص موجب له، وهنا الدليل المثبت للحكم غير متعرض للازمنة أصلا فلا يكون ثبوته في الازمنة بعد قيام الدليل بدليل مثبت له، ولهذا لا يكون قيام دليل النفي من دليل الخصوص في شئ بل يكون نسخا، كما بيناه في باب النسخ، يوضحه أنه لما لم يكن ذلك الدليل عاملا الآن في شئ صار قول المتمسك به لا دليل على ارتفاعه كلاما محتملا، كما أن قول خصمه قام الدليل على ارتفاعه كلام محتمل فتتحقق المعارضة بينهما على وجه لا يكون زعم أحدهما حجة على الآخر ما لم يرجح قوله بدليل.
وعلى هذا الاصل قلنا في الصلح على الانكار إنه جائز، لان الدليل المثبت لبراءة ذمة المنكر أو للملك له فيما في يده غير متعرض للبقاء أصلا فكان دعوى المدعي أن المدعي حقي وملكي خبرا محتملا، وإنكار المدعى عليه لذلك خبر محتمل أيضا فكما لا يكون خبر المدعي حجة على المدعى عليه في إلزام التسليم إليه لكونه محتملا، فكذلك خبر المدعي عليه لا يكون حجة على المدعي في فساد الاعتياض عنه بطريق الصلح، ولهذا لو صالحه أجنبي على مال جاز بالاتفاق، ولو ثبت براءة ذمته في حق المدعي بدليل كما ذكره
الخصم لم يجز صلحه مع الاجنبي، كما لو أقر أنه مبطل في دعواه ثم صالح مع أجنبي.
والدليل عليه فصل الشهادة بعتق العبد على مولاه فإن الشاهد إذا اشتراه صح الشراء ولزمه الثمن لهذا المعنى، وهو أن ما أخبر به الشاهد لكونه محتملا لم يصر حجة على مولى العبد حتى جاز له الاعتياض عنه بالبيع من غيره، فيجوز له الاعتياض عنه بالبيع من الشاهد وإن كان زعمه معتبرا في حقه حتى إنه يعتق كما اشتراه لا من جهته حتى لا يكون ولاؤه له، وما كان ذلك إلا بالطريق الذي قلنا، فإن الدليل الموجب للملك للمولى لا يكون دليل بقاء ملكه بل بقاء الملك بعد ثبوته لاستغنائه عن الدليل المنفي.
وعلى هذا الاصل قلنا: مجهول الحال يكون حرا باعتبار الظاهر، ولكن لو جنى عليه جناية
فزعم الجاني أنه رقيق لا يلزمه أرش الجناية على الاحرار حتى تقوم البينة على حريته، لان ثبوت الحرية للحال ليس بدليل موجب لذلك بل باعتبار أصل الحرية لاولاد آدم وذلك لا يجوب البقاء فكان عدواه الحرية لنفسه فئ الحال محتملا ودعوى الغير الرق عليه محتمل، فبالمحتمل لا يثبت الرق عليه محتمل، فبالمحتمل لا يثبت الرق فيه لغيره ويجعل القول قوله في الحرية، وبالمحتمل لا يثبت دعوى استحقاق أرش الاحرار بسبب الجناية عليه غيره حتى يقيم البينة على حريته، لان قبل إقامة البينة ليس معه إلا الاحتجاج بلا دليل وذلك دافع عنه ولا يكون حجة له على غيره.
وعلى هذا لو قذف إنسانا ثم زعم أنه عبد وقال المقذوب بل هو حر، فإنه لايقام حد الاحرار عليه حتى تقوم البينة للمقذوف على حريته.
وكذلك لو قطع يد إنسان ثم زعم أنه عبد وأنه لاقصاص عليه.
وكذلك لو شهد في حادثة ثم زعم المشهود عليه أنه عبد فإن شهادته لا تكون حجة حتى تقوم البينة على حريته.
والشافعي رحمه الله يخالفنا في جميع ذلك للاصل الذى بينا له.
وعلى هذا لو اشترى شقصا من دار فطلب الشفيع الشفعة وقال
المشترى ما في يدك مما تدعى به الشفعة ليس بملك لك بل هي ملكى فإنه يكون القول قول مدعى الشفعة في دفع دعوى المشترى عما في يده، ويكون القول قول المشترى في إنكاره حق الشفعة له، حتى إن لشفيع ما لم يقم البينة على أن العين الذى في يده ملكه لا يستحق الشفعة عندنا، لان خبر كل واحد منهما محتمل فلا يكون حجة على خصمه في استحقاق ما في يده.
وعند الشافعي ملك الشفيع فيما في يده ثابت باعتبار أن قوله مستند إلى دليل ثبت فيستحق به الشفعة.
ونظير ما قاله علماؤنا قول المولى لعبده: إن لم أدخل اليوم الدار فأنت حر، ثم قال المولى بعد مضى اليوم قد دخلت وقال العبد لم تدخل، فإن القول قول المولى حتى لا يعتق العبد، ومعلوم أن قول العبد مستند إلى دليل من حيث الظاهر وهو أن الاصل عدم الدخول ولكن لما كان قوله في الحال محتملا قول المولى كذلك لم يثبت استحقاقه على المولى بما هو محتمل.
وكذلك المفقود فإنه لا يرث أحدا من أقاربه إذا مات قبل أن يظهر حاله
ومعلوم أن بقاءه حيا مستند إلى دليل وهو ما علم من حياته، ولكن لما لم يكن ذلك دليلا للبقاء اعتبر في الحال الاحتمال، فقيل لا يرثه أحد لاحتمال بقائه حيا، ولا يرث أحدا لاحتمال أنه ميت.
فإن قيل: عندي إذا استند قوله إلى دليل إنما يقبل قوله على خصمه في إبقاء ما هو مقصود له: في مسألة العتق لا مقصود للعبد في نفى دخول المولى الدار وإنما مقصوده في العتق ودعواه العتق ليس بمستند إلى دليل مثبت له.
وكذلك عدوى من يدعى حياة المفقود بعد ما مات قريب له ليس بمقصود للمدعى حتى يعتبر فيه الاستناد إلى دليله،
فأما دعوى المنكر براءة ذمته أو كون ما في يده ملكا له مقصود له وهو يستند إلى دليل كما بينا.
وكذلك دعوى مجهول الحال الحرية لنفسه مقصود له.
ودعوى الشفيع الملك لنفسه فيما في يده مقصود له، فإذا كان هذا مستندا إلى دليله وهو مقصود له كان حجة له على خصمه.
قلنا: لا فرق، فإن دعوى المنكر فساد الصلح غير مقصود له ولكن يترتب عليه ما هو المقصود له وهو سقوط المطالبة عنه بتسليم ما التزمه بالصلح، كما أن دعوى العبد أن المولى لم يدخل الدار غير مقصود له ولكن يترتب عليه ما هو مقصود له وهو عتقه باعتبار وجود الشراط.
ثم هناك لكون ما أخبر به محتملا لم يجعل حجة على خصمه، ولا يعتبر استناده إلى دليل باعتبار الاصل، فكذلك في مسألة الصلح فصل ومن الاحتجاج بلا دليل الاستدلال باستصحاب الحال، وذلك نحو ما يقول بعض أحصابنا في حكم الزكاة في مال الصبى إن الاصل عدم الوجوب فيستصحبه حتى يقوم دليل الوجوب، وفى الاستئناف أن وجوب الحقتين في مائة وعشرين ثابت بالنص والاجماع فيجب استصحابه حتى يقوم الدليل المغير، وهذا النوع من التعليل باطل، فإن ثبوت العدم وإن كان بدليل معدم فذلك لا يوجب
بقاء العدم، كما أن الدليل الموجد للشئ لا يكون دليل بقائه موجودا فكذلك الدليل المثبت للحكم لا يكون دليل بقائه ثابتا، ألا ترى أن عدم الشراء لا يمنع وجود الشراء في المستقبل، والشراء الموجب للملك لا يمنع انعدام الملك بدليله في المستقبل، ولكن البقاء بعد الوجود لاستغنائه عن الدليل، لا لان الدليل المثبت له موجب لبقائه، كما أن ثبوت الحياة بسببه لا يكون
دليل بقاء الحياة، يوضحه أن بعد ثبوت حكم هو نفي إيجاده يستدعي دليلا، فمن ادعى وجوده احتاج إلى إثباته على خصمه بدليل.
وكذلك من ادعى بقاءه منفيا فهو محتاج إلى إثباته بدليله على الخصم، إذ الدليل الاول غير موجب لذلك فليس أحدهما بالاحتجاج على صاحبه لعدم قيام الدليل بأولى من الآخر، وما كان البقاء فيما يحتمل البقاء بعد الوجود إلا نظير الوجود في الاعراض التي لا تبقى وقتين، فإن وجود شئ منه بدليل لا يكون دليل وجود مثله في الوقت الثاني.
وبيان هذا في البعير الزائد على المائة والعشرين فإن عند الخصم ينتهي به عفو الحقتين فيتم به نصاب ثلاث بنات لبون.
وعندنا هو ابتداء العفو لنصاب آخر، وليس في إيجاب الحقتين في مائة وعشرين ما يدل على واحد من الامرين، فكان الاحتجاج به لايجاب الحقتين بعد هذه الزيادة عند كمال الحول يكون احتجاجا بلا دليل.
ثم استصحاب الحال ينقسم أربعة أقسام: أحدها استصحاب حكم الحال مع العلم يقينا بانعدام الدليل المغير، وذلك بطريق الخبر عمن ينزل عليه الوحي أو بطريق الحس فيما يعرف به، وهذا صحيح قد علمنا الاستدلال به في قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية، وهذا لانه لما علم يقينا بانعدام الدليل المغير وقد كان الحكم ثابتا بدليله وبقاؤه يستغني عن الدليل فقد علم بقاؤه ضرورة.
والثاني: استصحاب حكم الحال بعد دليل مغير ثابت بطريق النظر
والاجتهاد بقدر الوسع، وهذا يصلح لابلاء العذر وللدفع ولا يصلح للاحتجاج به على غيره، لان المتأمل وإن بالغ في النظر فالخصم يقول قام الدليل عندي بخلافه، وبالتأمل والاجتهاد لا يبلغ المرء درجة يعلم بها يقينا أنه لم يخف
عليه شئ من الادلة، بل يبقى له احتمال اشتباه بعض الادلة عليه، وما كان في نفسه محتملا عنده لا يمكنه أن يحتج به على غيره.
والثالث: استصحاب حكم الحال قبل التأمل والاجتهاد في طلب الدليل المغير وهذا جهل، لان قبل الطلب لا يحصل له شئ من العلم بانتفاء الدليل المغير ظاهرا ولا باطنا، ولكنه يجهل ذلك بتقصير منه في الطلب، وجهله لا يكون حجة على غيره ولا عذرا في حقه أيضا إذا كان متمكنا من الطلب إلا أن لا يكون متمكنا منه.
وعلى هذا قلنا: إذا أسلم الذمي في دار الاسلام ولم يعلم بوجوب العبادات عليه حتى مضى عليه زمان فعليه قضاء ما ترك، بخلاف الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب العبادات عليه حتى مضى زمان.
وعلى هذا قلنا: من لم يجتهد بعد الاشتباه في أمر القبلة حتى صلى إلى جهة فإنه لا تجزيه صلاته ما لم يعلم أنه أصاب، بخلاف ما إذا اجتهد وصلى إلى جهة فإنه تجزيه صلاته وإن تبين أنه أخطأ.
والنوع الرابع: استصحاب الحال (لاثبات الحكم ابتداء، وهذا خطأ محض وهو ضلال محض ممن يتعمده لان استصحاب الحال) كاسمه، وهو التمسك بالحكم الذي كان ثابتا إلى أن يقوم الدليل المزيل، وفي إثبات الحكم ابتداء لا يوجد هذا المعنى، ولا عمل لاستصحاب الحال فيه صورة ولا معنى، وقد بينا في مسألة المفقود أن الحياة المعلومة باستصحاب الحال يكون حجة في إبقاء ملكه في ماله على ما كان، ولا يكون حجة في إثبات الملك له ابتداء في مال قريبه إذا مات.
وبعض أصحاب الشافعي يجعلونه حجة في ذلك، لا باعتبار أنهم يجوزون إثبات الحكم ابتداء باستصحاب الحال، بل باعتبار أنه يبقى للوارث
الملك الذي كان للمورث، فإن الوراثة خلافة، وقد بينا أن عنده استصحاب
الحال فيما يرجع إلى الابقاء حجة على الغير.
ولكنا نقول: هذا البقاء في حق المورث، فأما في حق الوارث فصفة المالكية تثبت له ابتداء واستصحاب الحال لا يكون حجة فيه بوجه.
وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا ادعى عينا في يد إنسان أنه له ميراث من أبيه وأقام الشاهدين فشهدا أن هذا كان لابيه لم تقبل هذه الشهادة.
وفي قول أبي يوسف الآخر تقبل، لان الوراثة خلافة فإنما يبقى للوارث الملك الذي كان للمورث، ولهذا يرد بالعيب ويصير مغرورا فيما اشتراه المورث، وما ثبت فهو باق لاستغناء البقاء عن دليل.
وهما يقولان في حق الوارث: هذا في معنى ابتداء التملك، لان صفة المالكية تثبت له في هذا المال بعد أن لم يكن مالكا، وإنما يكون البقاء في حق المورث أن لو حضر بنفسه يدعي أن العين ملكه فلا جرم إذا شهد الشاهدان أنه كان له كانت شهادة مقبولة كما إذا شهدا أنه له، فأما إذا كان المدعي هو الوارث وصفة المالكية للوارث تثبت ابتداء بعد موت المورث فهذه الشهادة لا تكون حجة للقضاء بالملك له، لان طريق القضاء بها استصحاب الحال وذلك غير صحيح.
فصل ومن هذه الجملة الاستدلال بتعارض الاشباه، وذلك نحو احتجاج زفر رحمه الله في أنه لا يجب غسل المرافق في الوضوء، لان من الغايات ما يدخل ومنها ما لا يدخل فمع الشك لا تثبت فرضية الغسل فيما هو غاية بالنص، لان هذا في الحقيقة احتجاج بلا دليل لاثبات حكم، فإن الشك الذي يدعيه أمر حادث فلا يثبت حدوثه إلا بدليل.
فإن قال: دليله تعارض الاشباه.
قلنا: وتعارض الاشباه أيضا حادث فلا يثبت إلا بالدليل.
فإن قال: الدليل عليه ما أعده من الغايات مما يدخل بالاجماع وما لا يدخل بالاجماع.
قلنا: وهل تعلم أن هذا المتنازع فيه
من أحد النوعين بدليل ؟ فإن قال أعلم ذلك.
قلنا: فإذن عليك أن لا تشك فيه بل
تلحقه بما هو من نوعه بدليله.
وإن قال: لا أعلم ذلك.
قلنا: قد اعترفت بالجهل، فإن كان هذا مما يمكن الوقوف عليه بالطلب فإنما جهلته عن تقصير منك في طلبه وذلك لا يكون حجة أصلا، وإن كان مما لا يمكن الوقوف عليه بعد الطلب كنت معذورا في الوقوف فيه، ولكن هذا العذر لا يصير حجة لك على غيرك ممن يزعم أنه قد ظهر عنده دليل إلحاقه بأحد النوعين، فعرفنا أن حاصل كلامه احتجاج بلا دليل.
فصل ومن هذه الجملة الاحتجاج بالاطراد على صحة العلة إما وجودا أو وجودا وعدما، فإنه احتجاج بلا دليل في الحقيقة، ومن حيث الظاهر هو احتجاج بكثرة أداء الشهادة، وقد بينا أن كثرة أداء الشهادة وتكرارها من الشاهد لا يكون دليل صحة شهادته.
ثم الاطراد عبارة عن سلامة الوصف عن النقوض والعوارض، والناظر وإن بالغ في الاجتهاد بالعرض على الاصول المعلومة عنده فالخصم لا يعجز من أن يقول عندي أصل آخر هو مناقض لهذا الوصف أو معارض، فجهلك به لا يكون حجة لك علي، فتبين من هذا الوجه أنه احتجاج بلا دليل، ولكنه فوق ما تقدم في الاحتجاج به من حيث الظاهر، لان من حيث الظاهر الوصف صالح، ويحتمل أن يكون حجة للحكم إذا ظهر أثره عند التأمل، ولكن لكونه في الحقيقة استدلالا على صحته بعدم النقوض والعوارض لم يصلح أن يكون حجة لاثبات الحكم.
فإن قيل: أليس أن النصوص بعد ثبوتها يجب العمل بها، واحتمال ورود الناسخ لا يمكن شبهة في الاحتجاج بها قبل أن يظهر الناسخ فكذلك
ما تقدم ؟ قلنا: أما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا احتمال للنسخ في كل نص كان حكمه ثابتا عند وفاته، فأما في حال حياته فهكذا نقول: إن الاحتجاج به لاثبات الحكم ابتداء صحيح، فأما لابقاء الحكم أو لنفي الناسخ لا يكون صحيحا، لان احتمال بقاء الحكم واحتمال قيام دليل النسخ فيه كان بصفة واحدة، وقد قررنا هذا في باب النسخ.
ثم الطرديات الفاسدة أنواع.
منها ما لا يشكل فساده على أحد.
ومنها ما يكون (بزيادة وصف في الاصل به يقع الفرق.
ومنها ما يكون) بوصف مختلف فيه اختلافا ظاهرا.
ومنها ما يكون استدلالا بالنفي والعدم.
وبيان النوع الاول: فيما علل به بعض أصحاب الشافعي لكون قراءة الفاتحة ركنا في الصلاة لانها عبادة ذات أركان لها تحليل وتحريم، فكان من أركان ما له عدد السبع كالحج في حق الطواف، وربما يقولون: الثلاث أحد عددي مدة المسح فلا يتأدى به فرض القراءة في الصلاة كالواحد، وما دون الثلاث قاصر عن السبع فلا يتأدى به فرض القراءة كما دون الآية.
ونحو ما يحكى عن بعضهم في أن الرجعة لا تحصل بالفعل، لان الوطئ فعل ينطلق مرة ويتعلق أخرى فلا تثبت به الرجعة كالقتل.
ونحو ما يحكى عن بعض أصحابنا في الوضوء بغير النية أن هذا حكم متعلق بأعضاء الطهارة فلا تشترط النية في إقامته كالقطع في السرقة والقصاص.
هذا النوع مما لا يخفى فساده على أحد، ولم ينقل من هذا الجنس شئ عن السلف إنما أحدثه بعض الجهال ممن كان بعيدا من طريق الفقهاء، فأما علل السلف ما كانت تخلو عن الملاءمة أو التأثير، ولهذا كان الواحد منهم يتأمل مدة فلا يقف في حادثة إلا على قياس أو قياسين، والواحد من المتأخرين ربما
يتمكن في مجلس واحد من أن يذكر في حادثة خمسين علة من هذا النحو أو أكثر، ولا مشابهة بين غسل الاعضاء في الطهارة وبين القطع في السرقة، ولا بين مدة المسح والقراءة في الصلاة، ولا بين الطواف بالبيت وقراءة الفاتحة، فعرفنا أن هذا النوع مما لا يخفى فساده.
وأما ما يكون بزيادة وصف فنحو تعليل بعض أصحاب الشافعي في مس الذكر إنه حدث، لانه مس الفرج فينتقض الوضوء به كما لو مسه عند البول، فإن هذا القياس لا يستقيم إلا بزيادة وصف في الاصل وبذلك
الوصف يثبت الفرق بين الفرع والاصل ويثبت الحكم به في الاصل.
وكذلك قولهم في إعتاق المكاتب عن الكفارة إنه تكفير بتحرير المكاتب فلا يجوز، كما لو أدى بعض بدل الكتابة ثم أعتقه، لان استقامة هذا القياس بزيادة وصف في الاصل به يقع الفرق، وهو أن المستوفى من البدل يكون عوضا، والتكفير لا يجوز بالاعتاق بعوض.
ونحو ما علل بعضهم في شراء الاب بنية الكفارة إنه تكفير بتحرير أبيه فلا يجوز، كما لو كان حلف بعتقه إن ملكه، فإن استقامة هذا التعليل بزيادة وصف به يقع الفرق من حيث إن المحلوف بعتقه إذا عتق عند وجود الشرط لا يصير مكفرا به وإن نواه عند ذلك أبا كان أو أجنبيا.
والنوع الثالث: نحو ما يعلل به بعض أصحاب الشافعي في أن الاخ لا يعتق على أخيه إذا ملكه.
قال: عتق الاخ تتأدى به الكفارة فلا يثبت بمجرد الملك كعتق ابن العم.
وهذا تعليل بوصف مختلف فيه اختلافا ظاهرا، فإن عندنا عتق القريب وإن كان مستحقا عند وجود الملك تتأدى به الكفارة حتى قلنا: إذا اشترى أباه بنية الكفارة يجوز، خلافا
للشافعي رحمه الله.
ونحو ما علل به بعضهم في الكتاب الحالة أنها لا تمنع جواز التكفير بتحريره فتكون فاسدة كالكتابة على القيمة، فإن هذا تعليل بوصف مختلف فيه اختلافا ظاهرا، لان التكفير بإعتاق المكاتب كتابة صحيحة جائزة عندنا، وربما يكون هذا الاختلاف في الاصل نحو ما يعلل به بعض.
أصحاب الشافعي في الافطار بالاكل والشرب إنه إفطار بالمطعوم، فلا يوجب الكفارة كما لو كان في يوم أبصر الهلال وحده ورد الامام شهادته.
وأما النوع الرابع: فنحو تعليل الشافعي في النكاح إنه لا يثبت بشهادة النساء مع الرجال لانه ليس بمال، وفي الاخ لا يعتق على أخيه لانه ليس
بينهما بعضية، وفي المبتوتة إنه لا يلحقها الطلاق لانه ليس بينهما نكاح، وفي إسلام المروي بالمروي إنه يجوز لانه لم يجمع البدلين الطعم والثمنية، وهذا فاسد لانه استدلال بعدم وصف والعدم لا يصلح أن يكون موجبا حكما، وقد بينا أن العدم الثابت بدليل لا يكون بقاؤه ثابتا بدليل فكيف يستدل به لاثبات حكم آخر.
فإن قيل: مثل هذا التعليل كثير في كتبكم.
قال محمد رحمه الله: ملك النكاح لا يضمن بالاتلاف لانه ليس بمال، والزوائد لا تضمن بالغصب لانه لم يغصب الولد.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: العقار لا يضمن بالغصب لانه لم ينقله ولم يحوله.
وقال فيما لا يجب فيه الخمس: لانه لم يوجف عليه المسلمون.
وقال في تناول الحصاة: لا تجب الكفارة لانه ليس بمطعوم.
وقال في الجد: لا يؤدي صدقة الفطر عن النافلة لانه ليس عليه ذلك.
فهذا استدلال بعدم وصف أو حكم.
قلنا: أولا هذا عندنا غير مذكور على وجه المقايسة بل على وجه الاستدلال
فيما كان سببه واحدا معينا بالاجماع نحو الغصب، فإن ضمان الغصب سببه واحد عين وهو الغصب، فالاستدلال بانتفاء الغصب على انتفاء الضمان يكون استدلالا بالاجماع.
وكذلك وجوب ضمان المال بسبب يستدعي المماثلة بالنص وله سبب واحد عين وهو إتلاف المال، فيستقيم الاستدلال بانتفاء المالية في المحل على انتفاء هذا النوع من الضمان، وكذلك إذا كان دليل الحكم معلوما في الشرع بالاجماع نحو الخمس فإنه واجب في الغنيمة لا غير وطريق الاغتنام الايجاف عليه بالخيل والركاب، فالاستدلال به لنفي الخمس يكون استدلالا صحيحا، وقد بينا أنه إبلاء العذر في بعض المواضع لا الاحتجاج به على الخصم.
فأما تعليل النكاح بأنه ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال يكون تعليلا بعدم الوصف وعدم الوصف لا يعدم الحكم لجواز أن يكون الحكم ثابتا باعتبار وصف آخر، لانه وإن لم يكن مالا فهو من جنس ما يثبت مع الشبهات والاصل المتفق عليه الحدود والقصاص، وبهذا الوصف لا يصير النكاح بمنزلة الحدود والقصاص حتى يثبت مع الشبهات بخلاف الحدود والقصاص، فعرفنا أن بعدم هذا الوصف لا ينعدم وصف آخر يصلح التعليل به لاثباته بشهادة
النساء مع الرجال.
وكذلك ما علل به من أخوات هذا الفصل فهو يخرج على هذا الحرف إذا تأملت.
فصل ومن هذا النوع الاحتجاج بأن الاوصاف محصورة عند القائسين، فإذا قامت الدلالة على فساد سائر الاوصاف إلا وصفا واحدا تثبت به صحة ذلك الوصف ويكون حجة.
هذا طريق بعض أصحاب الطرد.
وقد جوز الجصاص رحمه الله تصحيح الوصف للعلة بهذا الطريق.
قال الشيخ رحمه الله: وقد كان
بعض أصدقائي عظيم الجد في تصحيح هذا الكلام، بعلة أن الاوصاف لما كانت محصورة وجميعها ليست بعلة للحكم بل العلة وصف منها، فإذا قام الدليل على فساد سائر الاوصاف سوى واحد منها ثبت صحة ذلك الوصف بدليل الاجماع كأصل الحكم، فإن العلماء إذا اختلفوا في حكم حادثة على أقاويل، فإذا ثبت بالدليل فساد سائر الاقاويل إلا واحدا ثبت صحة ذلك القول، وذلك نحو اختلاف العلماء في جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه، فإنا إذا أفسدنا قول من يقول بالرجوع إلى قول القائف، وقول من يقول بالقرعة، وقول من يقول بالتوقف إنه لا يثبت النسب من واحد منهما يثبت به صحة قول من يقول بأنه يثبت النسب منهما جميعا.
وإذا قال لنسائه الاربعة: إحداكن طالق ثلاثا ووطئ ثلاثا منهن حتى يكون ذلك دليلا على انتفاء المحرمة عنهن تعين بها الرابعة محرمة، فكان تقرب هذا من الادلة العقلية.
قال الشيخ: وعندي أن هذا غلط لا نجوز القول به، وهو مع ذلك نوع من الاحتجاج بالدليل.
أما بيان الغلط فيه وهو أن ما يجعله هذا القائل دليل صحة علته هو الدليل على فساده، لانه لا يمكنه سلوك هذا الطريق إلا بعد قوله بالمساواة بين الاوصاف في أن كل وصف منها صالح أن يكون علة للحكم، وبعد ثبوت هذه المساواة فالدليل الذي يدل على فساد بعضها هو الدليل على فساد ما بقي منها، لانه متى علم المساواة بين شيئين في الحكم ثم ظهر لاحدهما حكم بالدليل فذلك الدليل يوجب مثل
ذلك الحكم في الآخر، كمن يقول لغيره: اجعل زيدا وعمرا في العطية سواء ثم يقول أعط زيدا درهما، يكون ذلك تنصيصا على أنه يعطي عمرا أيضا درهما، فعرفنا أنه لا وجه للتحرز عن هذا الفساد إلا ببيان تفاوت بين هذا الوصف وبين سائر الاوصاف في كونه علة للحكم، وذلك التفاوت لا يتبين إلا ببيان التأثير
أو الملاءمة فيضطر إلى بيانه شاء أو أبى، ثم وإن قام الدليل على فساد سائر الاوصاف على وجه لا عمل لذلك الدليل في إفساد هذا الوصف الواحد، فنحن نتيقن أن ذلك الدليل كما لا يوجب فساد هذا الوصف لا يوجب صحته، فلا يبقى على تصحيح هذا الوصف دليلا سوى أنه لم يقم الدليل على فساده، ولو جاز إثبات الوصف موجبا للحكم بهذا الطريق لجاز إثبات الحكم بدون هذا الوصف بهذا الطريق، وهو أن يقول حكم الحادثة كذا لانه لم يقم الدليل على فساد هذا الحكم، وما قاله من الاستدلال بالحكم فهو وهم، لان بإفساد مذهب الخصم لا يثبت صحة مذهب المدعي للحكم بوجه من الوجوه، وكيف يثبت ذلك والمبطل دافع والمدعي للحكم مثبت وحجة الدفع غير حجة الاثبات.
ثم الدليل على أن بقيام دليل الفساد في سائر الاوصاف لا تثبت صحة الوصف الذي ادعاه المعلل في الشرعيات أن من أحكام الشرع ما هو غير معلول أصلا بل الحكم فيه ثابت بالنص، فبقيام الدليل على فساد سائر الاوصاف لا ينعدم احتمال قيام الدليل على فساد هذا الوصف حقيقة ولا حكما من هذا الوجه، لجواز أن يكون هذا النص غير معلول أصلا، وبه فارق العقليات، ثم احتمال الصحة والفساد في هذا الوصف بالاجماع كان مانعا من جعله حجة لاثبات الحكم قبل قيام الدليل على فساد سائر الاوصاف، فكذلك بعده لان احتمال تعينه قائم.
باب: وجوه الاعتراض على العلل قال رضي الله عنه: العلل نوعان: طردية ومؤثرة.
والاعتراض على كل نوع من وجهين: فاسد وصحيح.
فالاعتراضات الفاسدة على العلل المؤثرة أربعة: المناقضة، وفساد الوضع، ووجود الحكم مع عدم العلة، والمفارقة بين
الاصل والفرع.
والصحيحة أربعة: الممانعة، ثم القلب المبطل، ثم العكس
الكاسر، ثم المعارضة بعلة أخرى.
فأما المناقضة فإنها لا ترد على العلل المؤثرة، لان التأثير لا يتبين إلا بدليل الكتاب أو السنة أو الاجماع.
وهذه الادلة لا تتناقض، فإن أحكام الشرع عليها تدور ولا تناقض في أحكام الشرع، وقد بينا أنه لا توجد العلة بدون الحكم على الوجه الذي ظهر أثرها في الحكم، بل لا بد أن ينعدم الحكم لتغير وصف بنقصان أو زيادة، وبه تتبدل العلة فتنعدم العلة المؤثرة التي أثبت المعلل الحكم بها، وانعدام الحكم عند انعدام العلة لا يكون دليل انتقاض العلة.
وهو نظير الشاهد فإنه مع استجماع شرائط الاداء إذا ترك لفظة الشهادة أو زاد عليها فقال فيما أعلم فإنه لا يجوز العمل بشهادته، وكان ذلك باعتبار انعدام العلة الموجبة للعمل بشهادته معنى.
وبيان هذا أنا إذا عللنا في تكرار المسح بالرأس أنه مسح مشروع في الطهارة فلا يستن تثليثه كالمسح بالخف لا يدخل الاستنجاء بالاحجار نقضا، لان المسح هناك غير مشروع في الطهارة إنما المشروع إزالة النجاسة العينية حتى لو تصور خروج الحدث من غير أن يتنجس شئ مما هو طاهر لم يجب المسح أصلا، وإزالة النجاسة غير المسح وهو لا يحصل بالمرة إلا نادرا، فعرفنا أن انعدام الحكم لانعدام العلة.
وأما فساد الوضع فهو اعتراض فاسد على العلة المؤثرة، لانه دعوى لا يمكن تصحيحها، فإن تأثير العلة إنما يثبت بدليل موجب للحكم كما بينا، ومعلوم أنه لا يجوز دعوى فساد الوضع في الكتاب والسنة والاجماع.
وأما وجود الحكم مع عدم العلة فإن الحكم يجوز أن يكون ثابتا بعلة أخرى، لان ثبوته بعلة لا ينافي كونه ثابتا بعلة أخرى، ألا ترى أن الحكم يجوز أن يثبت بشهادة الشاهدين، ويجوز أن يثبت بشهادة أربعة
حتى إذا رجع اثنان قبل القضاء يبقى القضاء واجبا بشهادة الباقيين.
وكذلك يجوز أن يكون الاصل معلولا بعلتين يتعدى الحكم بإحداهما إلى فروع
وبالاخرى إلى فروع أخر فلا يكون انعدام العلة مع بقاء الحكم في موضع ثابتا بالعلة الاخرى دليل فساد العلة.
فأما المفارقة فمن الناس من ظن أنها مفاقهة، ولعمري المفارقة مفاقهة ولكن في غير هذا الموضع، فأما على وجه الاعتراض على العلل المؤثرة تكون مجادلة لا فائدة فيها في موضع النزاع.
وبيان هذا من وجوه ثلاثة: أحدها أن شرط صحة القياس لتعدية الحكم إلى الفروع تعليل الاصل ببعض أوصافه لا بجميع أوصافه، وقد بينا أنه متى كان التعليل بجميع أوصاف الاصل لا يكون مقايسة، فبيان المفارقة بين الاصل والفرع بذكر وصف آخر لا يوجد ذلك في الفرع ويرجع إلى بيان صحة المقايسة، فأما أن يكون ذلك اعتراضا على العلة فلا.
ثم ذكر وصف آخر في الاصل يكون ابتداء دعوى والسائل جاهل مسترشد في موقف المنكر إلى أن تتبين له الحجة لا في موضع الدعوى، وإن اشتغل بإثبات دعواه فذلك لا يكون سعيا في إثبات الحكم المقصود وإنما يكون سعيا في إثبات الحكم في الاصل وهو مفروغ عنه، ولا يتصل ما يثبته بالفرع إلا من حيث إنه ينعدم ذلك المعنى في الفرع وبالعدم لا يثبت الاتصال، وقد بينا أن العدم لا يصلح أن يكون موجبا شيئا، فكان هذا منه اشتغالا بما لا فائدة فيه.
والثالث ما بينا أن الحكم في الاصل يجوز أن يكون معلولا بعلتين ثم يتعدى الحكم إلى بعض الفروع بإحدى العلتين دون الاخرى، فبان انعدام في الفرع الوصف الذي يروم به السائل الفرق، وإن سلم له أنه علة لاثبات
الحكم في الاصل فذلك لا يمنع المجيب من أن يعدي حكم الاصل إلى الفرع بالوصف الذي يدعيه أنه علة للحكم، وما لا يكون قدحا في كلام المجيب فاشتغال السائل به يكون اشتغالا بما لا يفيد، وإنما المفاقهة في الممانعة حتى يبين المجيب تأثير علته، فالفقه حكمة باطنة، وما يكون مؤثرا في إثبات الحكم شرعا فهو الحكمة الباطنة، والمطالبة به تكون مفاقهة،
فأما الاعراض عنه والاشتغال بالفرق يكون قبولا لما فيه احتمال أن لا يكون حجة لاثبات الحكم، واشتغالا بإثبات الحكم بما ليس بحجة أصلا في موضع النزاع وهو عدم العلة، فتبين أن هذا ليس من المفاقهة في شئ، والله أعلم.
فصل: الممانعة قال رضي الله عنه: اعلم بأن الممانعة أصل الاعتراض على العلة المؤثرة من حيث إن الخصم المجيب يدعي أن حكم الحادثة ما أجاب به، فإذا لم يسلم له ذلك يذكر وصفا يدعي أنه علة موجبة للحكم في الاصل المجمع عليه وأن هذا الفرع نظير ذلك الاصل، فيتعدى ذلك الحكم بهذا الوصف إلى الفرع، وفي هذا الحكم دعويان فهو أظهر في الدعوى من الاول، أي حكم الحادثة، وإن كانت المناظرة لا تتحقق إلا بمنع دعوى السابق عرفنا أنها لا تتحقق إلا بمنع هذه الدعاوى أيضا فيكون هو محتاجا إلى إثبات دعاويه بالحجة، والسائل منكر فليس عليه سوى المطالبة لاقامة الحجة بمنزلة المنكر في باب الدعاوى والخصومات، وإليه أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم حيث قال للمدعي: (ألك بينة) وبالممانعة يتبين العوار، ويظهر المدعي من المنكر، والملزم من الدافع بعدما ثبت شرعا أن حجة أحدهما
غير حجة الآخر.
ثم الممانعة على أربعة أوجه: ممانعة في نفس العلة، وممانعة في الوصف الذي يذكر المعلل أنه علة، وممانعة في شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك الوصف، وممانعة في المعنى الذي به صار ذلك الوصف علة للحكم.
أما الممانعة في نفس العلة فكما بينا أن كثيرا من العلل إذا تأملت فيها تكون احتجاجا بلا دليل، وذلك لا يكون حجة على الخصم لاثبات
الحكم.
وبيان هذا فيما علل به الشافعي رحمه الله في النكاح أنه ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال كالحدود والقصاص.
وهذا النوع لا يصلح حجة لايجاب الحكم عندنا على ما بينا، فترك الممانعة فيه تكون قبولا من الخصم ما لا يكون حجة أصلا وذلك دليل الجهل، فكانت الممانعة في هذا الموضع دليل المفاقهة.
وأما ممانعة الوصف الذي هو العلة فبيانه فيما علل به أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن الايداع من الصبي تسليط على الاستهلاك، فإن مثل هذا الوصف لا بد أن يكون ممنوعا عند الخصم، لان بعد ثبوته لا يبقى للمنازعة في الحكم معنى.
ونحو ما علل به أبو حنيفة فيمن اشترى قريبه مع غيره أن الاجنبي رضي بالذي وقع العتق به بعينه ونحو ما علل به علماؤنا في صوم يوم النحر أنه مشروع لانه منهي عنه، والنهي يدل على تحقق المشروع ليتحقق الانتهاء عنه كما هو موجب النهي، فإن عند الخصم مطلق النهي بمنزلة النسخ حتى ينعدم به المشروع أصلا.
فلا بد من هذه الممانعة لمن يريد الكلام في المسألة على سبيل المفاقهة.
وأما الممانعة في الشرط الذي لا بد منه ليصير الوصف علة، بيانه فيما
ذكرنا أن من الاوصاف ما يكون مغيرا حكم الاصل ومن شرط صحة العلة أن لا يكون مغيرا حكم النص، وذلك نحو تعليل الاشياء الاربعة بالطعم فإنه يغير حكم النص، لان الحكم في نصوص الربا حرمة الفضل على القدر وثبوت الحرمة إلى غاية وهو المساواة، والتعليل بالطعم يثبت في المنصوص حرمة فضل لا على القدر، وحرمة مطلقة لا إلى غاية المساواة، يعني في الحفنة من الحنطة، وفيما لا يدخل تحت القدر من المطعومات التي هي فرع في هذا الحكم، فلا بد من هذه الممانعة، لان الحكم لا يثبت بوجود ركن الشئ مع انعدام شرطه.
وأما الممانعة في المعنى الذي يكون به الوصف علة موجبة للحكم شرعا فهو المطالبة ببيان التأثير، لما بينا أن العلة به تصير موجبة للحكم شرعا وهي الحكمة الباطنة التي يعبر عنها بالفقه.
والحاصل أن في الدعوى والانكار يعتبر المعنى دون الصورة، فقد يكون المرء مدعيا صورة وهو منكر معنى، ألا ترى أن المودع إذا ادعى رد الوديعة يكون منكرا للضمان معنى، ولهذا كان القول قوله مع اليمين، وإنما جعل الشرع اليمين في جانب المنكر.
والبكر إذا قالت: بلغني النكاح فرددت، وقال الزوج بل سكتت، فالقول قولها عندنا، وهي في الصورة تدعي الرد ولكنها تنكر ثبوت ملك النكاح عليها في المعنى، فكانت منكرة لا مدعية.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما: إذا اختلف المتبايعان في الثمن بعد هلاك السلعة فالقول قول المشتري مع يمينه، وهو في الصورة يدعي بيعا بأقل الثمنين ولكنه في المعنى منكر للزيادة التي يدعيها البائع، فعرفنا أنه إنما يعتبر المعنى في الدعوى والانكار
دون الصورة.
إذا ثبت هذا فنقول: هذه الوجوه من الممانعة تكون إنكارا من السائل فلا حاجة به إلى إثبات إنكاره بالحجة، واشتغاله بذلك يكون اشتغالا بما لا يفيد، وقوله إن الحكم في الاصل ما تعلق بهذا الوصف فقط بل به وبقرينة أخرى يكون إنكارا صحيحا من حيث المعنى وإن كان دعوى من حيث الصورة، لان الحكم المتعلق بعلة ذات وصفين لا يثبت بوجود أحد الوصفين.
وذلك نحو ما يعلل به الشافعي رحمه الله في اليمين المعقودة على أمر في المستقبل لانها يمين بالله مقصودة فيتعدى الحكم بهذا الوصف إلى الغموس.
فإنا نقول: الحكم في الاصل ثبت بهذا الوصف مع قرينة وهو توهم البر فيها فيكون هذا منعا لما ادعاه الخصم والخصم هو المحتاج إلى إثبات دعواه بالحجة.
فأما قول السائل: ليس المعنى في الاصل ما قلت وإنما المعنى فيه كذا، هو إنكار صورة ولكنه من حيث المعنى دعوى وهو دعوى غير مفيد في موضع النزاع، لانه لا يمكنه أن يقول في موضع النزاع لتقرير ذلك المعنى سوى أن هذا المعنى معدوم في موضع النزاع، وعدم العلة لا يوجب عدم الحكم وإن كان هذا يصلح للترجيح به من وجه، على ما نبينه إن شاء الله تعالى.
فصل: القلب والعكس قال رضي الله عنه: تفسير القلب لغة: جعل أعلى الشئ أسفله وأسفله أعلاه.
من قول القائل: قلبت الاناء إذا نكسه، أو هو: جعل بطن الشئ ظهرا والظهر بطنا.
من قول القائل: قلبت الجراب إذا جعل باطنه ظاهرا وظاهره باطنا، وقلبت الامر إذا جعله ظهرا لبطن.
وقلب العلة على هذين الوجهين.
وهو نوعان: أحدهما جعل المعلول علة والعلة معلولا،
وهذا مبطل للعلة، لان العلة هي الموجبة شرعا والمعلول هو الحكم الواجب به فيكون فرعا وتبعا للعلة، وإذا جعل التبع أصلا والاصل تبعا كان ذلك دليل بطلان العلة.
وبيانه فيما قال الشافعي في الذمي إنه يجب عليه الرجم لانه من جنس من يجلد بكره مائة فيرجم ثيبه كالمسلم.
فيقلب عليه فنقول: في الاصل إنما يجلد بكره لانه يرجم ثيبه فيكون ذلك قلبا مبطلا لعلته باعتبار أن ما جعل فرعا صار أصلا وما جعله أصلا صار تبعا.
وكذلك قوله: القراءة ركن يتكرر فرضا في الاوليين فيتكرر أيضا فرضا في الاخريين كالركوع.
وهذا النوع من القلب إنما يتأتى عند التعليل بحكم لحكم، فأما إذا كان التعليل بوصف لا يرد عليه هذا القلب، إذ الوصف لا يكون حكما شرعيا يثبت بحكم آخر.
وطريق المخلص عن هذا القلب أن لا يذكر هذا على سبيل التعليل بل على سبيل الاستدلال بأحد الحكمين على الآخر، فإن الاستدلال بحكم على حكم طريق السلف في الحوادث، روينا ذلك عن النبي عليه السلام وعن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن شرط هذا الاستدلال أن يثبت أنهما نظيران متساويان فيدل كل واحد منهما على صاحبه، هذا على ذاك في حال وذاك على هذا في حال، بمنزلة التوأم فإنه يثبت حرية الاصل لاحدهما أيهما كان بثبوته للآخر، ويثبت الرق في أيهما كان بثبوته للآخر، وذلك نحو ما يقوله علماؤنا رحمهم الله.
وبيانه فيما قال علماؤنا: إن الصوم عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحج، فلا يستقيم قلبهم علينا، لان الحج إنما يلزم بالنذر لانه يلزم بالشروع،
لانا نستدل بأحد الحكمين على الآخر بعد ثبوت المساواة بينهما من حيث إن المقصود بكل واحد منهما تحصيل عبادة زائدة هي محض حق الله تعالى،
على وجه يكون المعنى فيها لازما، والرجوع عنها بعد الاداء حرام، وإبطالها بعد الصحة جناية، فبعد ثبوت المساواة بينهما يجعل هذا دليلا على ذاك تارة وذاك على هذا تارة.
وكذلك قولنا في الثيب الصغيرة من يكون موليا عليه في ماله تصرفا يكون موليا عليه في نفسه تصرفا كالبكر، وفي البكر البالغة من لا يكون موليا عليه في ماله تصرفا لا يكون موليا عليه في نفسه تصرفا كالرجل، يكون استدلالا صحيحا بأحد الحكمين على الآخر، إذ المساواة قد تثبت بين التصرفين من حيث إن ثبوت الولاية في كل واحد منهما باعتبار حاجة المولى عليه وعجزه عن التصرف بنفسه، فلا يستقيم قلبهم إذا ذكرنا هذا على وجه الاستدلال، لان جواز الاستدلال بكل واحد منهما على الآخر يدل على قوة المشابهة والمساواة وهو المقصود بالاستدلال، بخلاف ما علل به الشافعي، فإنه لا مساواة بين الجلد والرجم، أما من حيث الذات فالرجم عقوبة غليظة تأتي على النفس والجلد لا، ومن حيث الشرط الرجم يستدعي من الشرائط ما لا يستدعي عليه الجلد كالثيوبة.
وكذلك لا مساواة بين ركن القراءة وبين الركوع، فإن الركوع فعل هو أصل في الركعة، والقراءة ذكر هو زائد، حتى إن العاجز عن الاذكار القادر على الافعال يؤدي الصلاة، والعاجز عن الافعال القادر على الاذكار لا يؤديها، ويسقط ركن القراءة بالاقتداء عندنا وعند خوف فوت الركعة بالاتفاق، ولا يسقط ركن الركوع.
وكذلك لا مساواة بين الشفع الثاني والشفع الاول في القراءة، فإنه يسقط في الشفع الثاني شطر ما كان مشروعا في الشفع الاول وهو قراءة السورة، والوصف المشروع فيه في الشفع الاول وهو الجهر بالقراءة، ومع انعدام المساواة لا يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر، والقلب يبطل التعليل على وجه المقايسة.
والنوع الثاني من القلب: هو جعل الظاهر باطنا بأن يجعل الوصف الذي
علل به الخصم شاهدا عليه لصاحبه في إثبات ذلك الحكم بعد أن كان شاهدا له، وهذه معارضة فيها مناقضة، لان المطلوب هو الحكم، فالوصف الذي يشهد بإثباته من وجه وينفيه من وجه آخر يكون متناقضا في نفسه، بمنزلة الشاهد الذي يشهد لاحد الخصمين على الآخر في حادثة، ثم للخصم الآخر عليه في عين تلك الحادثة فإنه يتناقض كلامه، بخلاف المعارضة بعلة أخرى فإنه لا يكون فيها معنى التناقض، بل للاشتباه يتعذر العمل إلى أن يتبين الرجحان لاحدهما على الآخر، فأما ما يشهد لك على خصمك وبخصمك عليك في حادثة واحدة في وقت واحد بأنه يتحقق فيه التعارض مع التناقض.
وبيان ذلك فيما علل به الشافعي في صوم رمضان بمطلق النية إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية كصوم القضاء.
فإنما نقلب عليه فنقول: إنه صوم فرض فبعد ما تعين مرة لا يشترط لادائه تعيين بنية أخرى كصوم القضاء.
وعلل في سنة التكرار في المسح بالرأس فإنه ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه واليدين.
فإنا نقلب عليه فنقول: ركن في الوضوء فبعد إكماله بالزيادة على المفروض في محل الفريضة لا يسن تثليثه كالمغسولات، وإقامة الفرض هنا يحصل بمسح الربع وبالاستيعاب يحصل الاكمال بالزيادة على الفريضة في محل الفريضة، كما في المغسولات بالغسل ثلاثا يحصل الاكمال بالزيادة على القدر المفروض وهو الاستيعاب في محل المفروض.
فإن قيل: هذا القلب إنما يتأدى بزيادة وصف، وبهذه الزيادة يتبدل الوصف ويصير شيئا آخر فيكون هذا معارضة لا قلبا.
قلنا: نعم في هذا زيادة وصف ولكنها تفسير للحكم على وجه التقرير له لا على وجه التغيير، فإنا نبين
بهذه الزيادة أن صوم رمضان لما تعين مشروعا في الزمان وغيره ليس بمشروع كان قياسه من القضاء ما بعد التعيين بالشروع فيه، والاستيعاب في المسح بالرأس لما لم يكن ركنا كان قياسه من المغسولات بعد حصول الاستيعاب ما إذا حصل الاكمال في المغسولات بالزيادة بعد الاستيعاب، فيكون تقريرا لذلك الوصف بهذا التفسير لا تغييرا.
وتفسير العكس لغة وهو: رد الشئ على سننه وراءه، مأخود من عكس المرآة، فإن نورها يرد نور بصر الناظر فيما وراءه على سننه حتى يرى وجهه كأن له في المرآة وجها وعينا يبصر به.
وكذلك عكس الماء نور الشمس، فإنه يرد نورها حتى يقع على جدار بمقابلة الماء كأن في الماء شمسا.
ثم العكس في العلة على وجهين: أحدهما رد الحكم على سننه بما يكون قلبا لعلته حتى يثبت به ضد ما كان ثابتا بأصله، نحو قولنا في الشروع في صوم النفل إن ما يلتزم بالنذر يلتزم بالشروع كالحج، وعكسه إن ما لا يلتزم بالنذر لا يلتزم بالشروع كالوضوء، فيكون العكس على هذا المعنى ضد الطرد، وهذا لا يكون قادحا في العلة أصلا بل يصلح مرجحا لهذا النوع من العلة على العلة التي تطرد ولا تنعكس على ما نبينه في بابه.
والنوع الآخر ما يكون عكسا يوجب الحكم لا على سنن حكم الاصل، بل على مخالفة حكم الاصل، وذلك نحو ما يعلل به الشافعي في أن الصوم عبادة لا يمضي في فاسدها فلا تصير لازمة بالشروع فيها كالوضوء، وعكسه الحج فهذا التعليل له، نظير التعليل الاول لنا، ونحن إذا قلنا بأن ما يلتزم بالنذر من العادة يلتزم بالشروع كالحج فهو يقول ينبغي أن يستوي حكم الشروع فيه بنية النفل وحكم الشروع فيه على ظن أنه عليه كالحج، فيكون في هذا العكس نوع
كسر للعلة حيث تمكن الخصم به من إثبات حكم هو مخالف للحكم الاول ولكنه ليس بقوي، فإن الحكم الذي تعلقه مجمل غير مفسر وما علقنا به من الحكم مفسر فالمفسر أولى من المجمل، ثم هو تعلق به حكم التسوية والحكم المقصود شئ آخر يختلف فيه الفرع والاصل على سبيل التضاد، فإن في الاصل يستويان حتى يجب القضاء فيهما، وفي الفرع عنده يستويان حتى يسقط القضاء فيهما، وإنما يستقيم هذا التعليل إذا كان المقصود عين التسوية، ولانه في هذا
العكس ينص على حكم آخر سوى ما ذكرناه في التعليل، فلا يكون إبطالا بطريق النظر وإنما يكون العكس دفعا لما فيه من الابطال والمناقضة، فإذا عرى عن ذلك لم يكن دفعا، ولانه علل بحكم مجمل لا يتصل بالمتنازع فيه إلا بكلام هو ابتداء وليس للسائل دلك، فظهر أن العكس سؤال ضعيف.
فصل في المعارضة وقد بينا تفسير المعارشة فيما مضى، وهذا الفصل لبيان إقسامها، وتمييز الفاسد من الصحيح منها.
فنقول: المعارضة نوعان: نوع في علة الاصل: ونوع في حكم الفرع.
فالذي في حكم الفرع على خمسة أوجه: معارضة بالتنصيص على خلاف حكم العلة في ذلك المحل بعينه، ومعارضة بتغيير هو تفسير لذلك الحكم على وجه التقرير له: ومعارضة بتغيير فيه إخلال بموضع الخلاف: ومعارضة فيها نفى ما لم يثبته المعلل أو إثبات ما لم ينفه المعلل ولكنه يتصل بموضع التعليل، ومعارضة بإثبات حكم في غير المحل الذى أثبت المعلل الحكم فيه بعلته والذى في علة الاصل أنواع ثلاثة: معارضة بذكر علة في الاصل لا تتعدى إلى فرع: ومعارضة بذكر علة تتعدى إلى فرع الحكم فيه متفق
عليه، ومعارضة بعلة تتعدى إل يفرع الحكم فيه مختلف فيه.
وبيان الوجه الاول من الاوجه الخمسة في تكرار المسح بالرأس، فإن الخصم يقول: ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالمغسول، ونحن نعارضه بقولنا: مسح في الطهارة فلا يسن تثليثه كالمسح بالخف، فهذه معارضة صحيحة لما فيها من التنصيص على خلاف حكم علته في ذلك المحل بعينه، وبيان الوجه الثاني في هذا الموضع أيضا، فإنا نقول: ركن في الوضوء فبعد صفة الاكمال بالزيادة على القدر المفروض في الفريضة لا يسن تثليثه كما في المغسولات.
فهقه معارضة بتغيير هو تفسير للحكم في تقريره.
وهذان وجهان في المعارضة المحوجة إلى الترجيح، لان عند صحة المعارضة يصار إلى الترجيح.
وبيان الوجه الثالث: فيما يعلل به في غير الاب والجد هل تثبت لهم ولاية التزويج على الصغيرة ؟ فنقول إنها صغيرة فتثبت علهيا ولاية التزويج كالتى لها أب، وهم يعارضون ويقولون: هذه صغيرة فلا تثبت عليها ولاية التزويج للاخ كالتى لها أب، فتكون هذه معارضة بتغيير فيه إخلال بموضع النزاع، لان موضع النزاع ثبوت ولاية التزويج على اليتيمة لاتعيين الولى الزوج لها، وهو في معارضته علل لنفى الولاية بشخص بعينه، ولكنه يقول: إن موضع النزاع إثبات الولاية للاقارب سوى الاب والجد على الصغيرة وأقربهم الاخ، فنحن بهذه المعارضة ننفي ولاية الاخ عنها، ثم ولاية من وراء الاخ منتفية عنها بالاخ، فمن هذا الوجه يظهر معنى الصحة في هذه العمارضة وإن لم يكن قويا.
وبيان الوجه الرابع فيما ذكرنا في النوع الثاني من العكس، وذلك فيما
يعلل به في مسألة الكافر يشترى عبدا مسلما إنه مال يملك الكافر بيعه فيملك شراءه كالعبد الكافر، فيقولون: وجب أن يستوى حكم شرائه ابتداء وحكم استدامة الملك فيه كالعبد الكافر الكافر.
فنقول: في هذه المعارضة إثبات ما لم ينفه بالتعليل وهو التسوية بين أصل الشراء وبين استدامة الملك به فلا تكون متصلة بموضع النزاع إلا بعد البناء بإثبات التسوية بين الاستدامة وابتداء الشراء، وليس للسائل هذا البناء، فلم تكن هذه المعارضة صحيحة بطريق النظر وإن كان يظهر فيها معنى الصحة عند إثبات التسوية بينهما.
وبيان الوجه الخامس فيما يقوله أبو حنيفة رضى الله عنه في المرأة إذا نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت بروج آخر وولدت منه أولادا ثم جاء الزوج الاول حيا، فإن نسب الاولاد يثبت من الاول لاونه صاحب فراش صحيح عليها وثبوت النسب باعتبار الفراش.
وهما يعارضان بأن الثاني صاحب فراش حاصر ومع صفة الفساد يثبت النسب من صاحب الفراش
كما لو تزوج امرأة بغير شهود ودخل بها، فهذه معارضة بإثبات حكم في غير المحل الذي وقع التعليل، إذ الفاسد غير الصحيح والكلام في أن النسب بعدما صار مستحقا بثبوته لشخص هل هو يجوز أن يثبت لغيره باعتبار فراشه، فإن الاول بفراشه السابق يصير مستحقا نسب أولادها ما بقي فراشها، فيقع الكلام بعد هذا في الترجيح، أن أصل الفراش للثاني باعتبار كونه حاضرا وكونه صاحب الماء هل يترجح على الفراش الصحيح الذي للغائب حتى ينتسخ به حكم الاستحقاق الثابت بفراشه أم لا ؟ وأبو حنيفة يقول: هذا لا يكون صالحا للترجيح، لان الشئ لا ينسخه إلا ما هو
مثله أو فوقه، والفاسد من الفراش مع هذه القرائن لا يكون مثلا للصحيح فلا ينسخ به حكم الاستحقاق الثابت بالصحيح، وبعدما صار النسب مستحقا لزيد لا يمكن إثباته لعمرو بوجه ما، والنكاح بغير شهود ليس من هذا المحل في شئ، فعرفنا أنه معارضة في غير محل الحكم.
فأما وجوه المعارضة في علة الاصل فهي فاسدة كلها لما بينا أن ذكر علة أخرى في الاصل لا يبقى تعليله بما ذكره المعلل، لجواز أن يكون في الاصل وصفان فيتعدى الحكم بأحد الوصفين إلى الفروع دون الآخر، ثم إن كان الوصف الذي يذكره المعارض لا يتعدى إلى فرع فهو فاسد، لما بينا أن حكم التعليل التعدية فما لا يفيد حكمه أصلا يكون فاسدا من التعليل، فإن كان يتعدى إلى فرع فلا اتصال له بموضع النزاع إلا من حيث إنه تنعدم تلك العلة في هذا الموضع، وقد بينا أن عدم العلة لا يوجب عدم الحكم، فعرفنا أنه لا اتصال لتلك العلة بموضع النزاع في النفي ولا في الاثبات، وكذلك إن كانت تتعدى إلى فرع مختلف فيه فالمتعدية إلى فرع مجمع عليه تكون أقوى من المتعدية إلى فرع مختلف فيه، ولما تبين فساد تلك تبين فساد هذا بطريق الاولى.
ومن الناس من يزعم أن هذه معارضة حسنة فيها معنى الممانعة، لان بالاجماع علة الحكم أحد الوصفين لا كلاهما فإذا ظهرت صحة علة السائل بظهور حكمها وهو التعدية يتبين فساد العلة الاخرى.
بيانه: أنا نقول في تعليل الحنطة إنه باع مكيلا بمكيل من جنسه متفاضلا، ثم تعدى الحكم بها إلى الحص وغيره.
والخصم يعارض فيقول: باع مطعوما بمطعوم من جنسه متفاضلا لتعدي الحكم به إلى المطعومات التي هي غير مقدرة كالتفاح
ونحوها، وقد ثبت باتفاق الخصمين أن علة الحكم أحدهما فإذا ثبت صحة ما ادعاه أحدهما علة انتفى الآخر بالاجماع، فكانت في هذه المعارضة ممانعة من هذا الوجه.
ولكنا نقول: لا تنافي بين العلتين ذاتا لجواز أن يعلق الحكم بكل واحد منهما، فمن أنكر صحة ما ادعاه خصمه من العلة لا يفسد ذلك بمجرد تصحيح علته بل بذكر معنى مفسد في علة خصمه، كما أنه لا يثبت وجه صحة علته بإفساد علة خصمه بل بمعنى هو دليل الصحة في علته، فعرفنا أن هذه المعارضة فاسدة أيضا.
ثم السبيل في كل كلام يذكره أهل الطرد على سبيل المفارقة إذا كان فقيها أن يذكره على وجه الممانعة فيكون ذلك فقها صحيحا من السائل على حد الانكار لا بد من قبوله منه.
وبيان ذلك أن الخصم يقول في عتق الرهن إن هذا تصرف من الراهن مبطل لحق المرتهن عن المرهون، فلا ينفذ بغير رضاه كالبيع، والفرق لنا بين هذا وبين البيع أن ذاك يحتمل الفسخ بعد وقوعه، فيمكن القول بانعقاده على وجه يتمكن المرتهن من فسخه، والعتق لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه، وهو بهذا التعليل يلغي أصل العتق ولا نسلم له هذا الحكم في الاصل، ثم من شرط صحة العلة أن لا يكون مغيرا حكم الاصل، فإن كان هو بالتعليل يغير حكم الاصل فيجعل الحكم فيه الالغاء دون الانعقاد على وجه التوقف منعناه من التعليل لانه ينعدم به شرط صحة التعليل، وإن أثبت به حكم الاصل وهو امتناع اللزوم بعد الانعقاد في محله لمراعاة حق المرتهن فهذا لا تصور له فيما لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه، وكذلك إن رده على إعتاق المريض فإن ذلك عندنا ليس يلغو،
فإن كان يعلل لالغاء العتق من الراهن فهذا تعليل يتغير به حكم الاصل وذلك غير صحيح عندنا فنمنعه بهذا الطريق، وعلى الوجه الذى هو حكم الاصل وهو
تأخير تنفيذ الوصية عن قضاء الدين لا يمكنه إثباته بهذا التعليل في الفرع فكانت الممانعة صحيحة بهذا الطريق، وكذلك تعليل الخصم في قتل العمد بأنه قتل آدمى مضمون فيكون موجبا للمال كالخطأ، فإن الفرق بين الفرع والاصل لاهل الطرف أن في الخطأ لا يمكن إيجاب مثل التلفف من جنسه وهنا المثل من جنسه واجب، والاولى أن يقول في الاصل المال إنما يجب حلفا عما هو الاصل لفوات الاصل، وهو بهذا التعليل يوجب المال في الفرع أصلا فيكون في هذا التعليل يعرض بحكم الاصل بالتغيير، وشرط صحة التعليل أن لا يكوم متعرضا لحكم الاصل، فنمنعه من التعليل بهذا الطريق حتى يكون كلاما من السائلا على حد الانكار صحيحا.
فصل في وجوه دفع المناقضة قد ذكرنا أن المناقضة لا ترد على العلل الؤثرة، لان دليل الصحة فيها بالتأثير الثابت بالاجماع، والنقض لايرد على الاجماع وإنما يرد النقض على العلل الطردية، لان دليل صحتها الاطراد وبالمناقضة ينعدم الاطراد، ثم تقع الحاجة إلى معرفة وجه دفع النقض صورة أو سؤالا معتبرا عن العلل.
والحاصل فيه أن المجيب متى وفق بين ما ذكر من العلة وبين ما يورد نقضا عليها بتوفيق بين فإنه يندفع النقض عنه، وإذا لم يمكنه التوفيق بينهما يلزمه سؤال النقض، بمنزلة التناقض الذى يقع في مجلس القاضى من الدعوى والشهادة وبين شهادة الشهود، فإن ذلك ينتفى بتوفيق صحيح بين ثم وجوه الدفع أربعة، دفع بمعنى الوصف الذى جعله علة بما هو ثابت بصيغته ظاهرا، ودفع بمعنى الوصف الذى هو ثابت بدلالته وهى التى صارت بها حجة وهو التأصير الذى قلنا، ودفع بالحكم الذى هو المقصود، ودفع بالفرض المطلوب بالتعليل.
فبيان الوجه الاول في تكرار المسح فإنا نقول: مسح فلا يسن تثليثه كالمسح بالخف، فيورد عليه الاستنجاء بالاحجار نقضا، فندفعه بمعنى الوصف الثابت بصيغته ظاهرا، وهو قولنا: مسح، فإن في الاستنجاء بالاحجار لا معتبر بالمسح بل المعتبر إزالة النجاسة حتى لو تصور خروج الحدث من غير أن يتلوث شئ منه من ظاهر البدن لا يجب المسح، والدليل عليه أن الاستطابة بالماء بعد إزالة عين النجاسة بالحجر فيه أفضل، ومعلوم أن في العضو الممسوح لا يكون الغسل بعد المسح أفضل، وكذلك إذا قلنا في الخارج من غير السبيلين إنه حدث لانه خارج نجس يورد عليه ما إذا لم يسل عن رأس الجرح: ودفع هذا النقض بمعنى الوصف ظاهرا وهو قولنا: خارج، فما لم يسل فهو طاهر لتقشير الجلد عنه وليس بخارج إنما الخارج ما يفارق مكانه وتحت كل موضع من الجلد بلة وفى كل عرق دم، فإذا تقشر الجلد عن موضع ظهر ما تحته فلا يكون خارجا كمن يكون في البيت إذا رفع البنيان الذى كان هو مستترا به يكون ظاهرا ولا يكون خارجا، وإنما يسمى خارجا من البيت إذا فارق مكانه، ولهذا لا يجب تطهير ذلك الموضع، لانه ما لم يصر خارجا من مكانه لا يعطى له حكم النجاسة.
وبيان الوجه الثاني في هذين الفصلين أيضا، فإن تأثير قولنا مسح أنه طهارة حكمية غير معقولة المعنى وهى مبنية على التخفيف، إلا ترى أنه لا تأثير للمسح في إثبات صفة الطهارة بعد تنجس المحل حقيقة، وأنه يتأدى ببعض المحل للتخفيف، فلا يرد عليه الاستنجاء، لان المطلوب هناك إزالة عين النجاسة ولهذا لا تنم باستعمال الحجر في بعض المحل دون العبض، فباعتبار الاستيعاب فيه والقصد إلى تطهير المحل بإزالة حقيقة النجاسة عنه يشبه
الاستنجاء الغسل في الاعضاء المغسولة دون المسح له وكذلك قولنا الخارج النجس كان حجة بالتأثير لها وهو وجوب التطهير في ذلك الموضع، فإن بالاجماع غسل ذلك الموضع للتطهير واجب ووجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لا يحتمل التجزى، فيندفع ما إذا لم تسل النجاسة لانه لم يجب
هناك تطهير ذلك الموضع بالغسل.
فعرفنا أنه انعدم الحكم لانعدام العلة، وهذا يكون مرجحا للعلة فكيف يكون نقضا ؟ ! وسنقرر هذا في بيان ترجيح العلة التي تنعكس على العلة التي لا تنعكس.
وبيان الوجه الثالث فيما يعلل به في النذر بصوم يوم النحر أنه يوم فيصح إضافة النذر إليه كسائر الايام، فيورد عليه يوم الحيض نقضا، ووجه الدفع بالحكم الذي هو المقصود بالتعليل وهو صحة إضافة النذر بالصوم إليه وذلك اليوم يصح إضافة النذر بالصوم إليه، فإنها لو قالت: لله علي أن أصوم غدا، يصح نذرها وإن حاضت من الغد، وإنما فسد نذرها بالاضافة إلى الحيض لا إلى اليوم.
وكذلك يعلل في التكفير بالمكاتب، فنقول: عقد الكتابة يحتمل الفسخ فلا تخرج الرقبة من جواز التكفير بعتقها كالبيع والاجارة، فيورد عليه نقضا ما إذا أدى بعض بدل الكتابة، وطريق الدفع بالحكم وهو أن هذا العقد لا يخرج الرقبة من أن تكون محلا للتكفير بها، وهنا العقد لا يخرج الرقبة من ذلك، ولكن معنى المعاوضة هو الذي يمنع صحة التكفير بذلك التحرير، وبعض أهل النظر يعبرون عن هذا النوع من الدفع بأن التعليل للجملة فلا يرد عليه الافراد نقضا، وفقهه ما ذكرنا.
وبيان الوجه الرابع من الدفع فيما عللنا به الخارج من غير السبيلين، فإنه خارج نجس فيكون حدثا كالخارج من السبيلين، فيورد عليه دم الاستحاضة
مع بقاء الوقت نقضا.
وللدفع فيه وجهان: أحدهما أن ذلك حدث عندنا ولكن يتأخر حكمه إلى ما بعد خروج الوقت ولهذا تلزمها الطهارة بعد خروج الوقت وإن لم يكن خروج الوقت حدثا، والحكم تارة يتصل بالسبب وتارة يتأخر عنه، فهذا الدفع من جملة الوجه الثالث ببيان أنه حدث بالجملة والثاني أن المقصود بهذا التعليل التسوية بين الفرع والاصل وقد سوينا، فإن الخارج المعتاد من السبيل إذا كان دائما يكون حدثا موجبا للطهارة بعد خروج الوقت لا في الوقت، فكذلك الذي هو غير المعتاد والذي هو خارج من غير سبيل.
وكذا إذا عللنا في أن السنة في التأمين الاخفاء بقولنا إنه ذكر لا يدخل عليه الاذان ولا التكبيرات التي يجهر بها الامام، لان الغرض التسوية بين التأمين
وبين سائر الاذكار في أن الاصل هو الاخفاء وذلك ثابت، إلا إن جهر الامام بالتكبيرات لا لانها ذكر بل لاعلام من خلفه بالانتقال من ركن إلى ركن، والجهر بالاذان والاقامة كذلك أيضا، ولهذا لا يجهر المقتدي بالتكبيرات ولا يجهر المنفرد بالتكبيرات ولا بالاذان والاقامة، فيدفع النقض ببيان الغرض المطلوب بالتعليل وهو التسوية بين هذا الذكر وبين سائر أذكار الصلاة.
وبعض أهل النظر يعبرون عن هذا فيقولون: مقصودنا بهذا التعليل التسوية بين الفرع والاصل وقد سوينا بينهما في موضع النقض كما سوينا في موضع التعليل، فيتبين به وجه التوفيق بطريق يندفع به التناقض، والله أعلم.
باب الترجيح قال رضي الله عنه: الكلام في هذا الباب في فصول: أحدها في معنى الترجيح لغة وشريعة، والثاني في بيان ما يقع به الترجيح، والثالث في بيان المخلص من تعارض يقع في الترجيح، والرابع في بيان ما هو فاسد من
وجوه الترجيح.
فأما الاول فنقول: تفسير الترجيح لغة إظهار فضل في أحد جانبي المعادلة وصفا لا أصلا، فيكون عبارة عن مماثلة يتحقق بها التعارض، ثم يظهر في أحد الجانبين زيادة على وجه لا تقوم تلك الزيادة بنفسها فيما تحصل به المعارضة أو تثبت به المماثلة بين الشيئين، ومنه الرجحان في الوزن فإنه عبارة عن زيادة بعد ثبوت المعادلة بين كفتي الميزان وتلك الزيادة على وجه لا تقوم منها المماثلة ابتداء ولا يدخل تحت الوزن منفردا عن المزيد عليه مقصودا بنفسه في العادة نحو الحبة في العشرة، وهذا لان ضد الترجيح التطفيف، وإنما يكون التطفيف بنقصان يظهر في الوزن أو الكيل بعد وجود المعارضة بالطريق الذي تثبت به المماثلة على وجه لا تنعدم به المعارضة، فكذلك الرجحان يكون بزيادة وصف على وجه لا تقوم به المماثلة ولا ينعدم بظهوره أصل المعارضة، ولهذا لا تسمى زيادة درهم على العشرة في أحد
الحانبين رجحانا، لان المماثلة تقوم به أصلا، وتسمى زيادة الحبة ونحوها رجحانا لان المماثلة لا تقوم بها عادة.
وكذل في لا شريعة هو عبارة عن زيادة تكون وصفا لا أصلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للوازن: " زن وأرجح فإنا معشر الانبياء هكذا زن " ولهذاد لا يثبت حكم الهبة في مقدار الرجحان، لانه زيادة تقوم وصفا لا مقصودا بسببه، بخلاف زيادة الدرهم على العشرة، فإنه يثبت فيه حكم الهبة حتى لو لم يكن متميزا كان الحكم فيه كالحكم في هبة المشاع لانه مما تقوم به المماثلة فإنه يكون مقصودا بالوزن فلا بد من أن يجعل مقصودا في التمليك بسببه وليس ذلك إلا الهبة، فإن قضاء العشرة يكون بمثلها عشرة، فيتبين أن بالرجحان لا ينعدم أصل المماثلة
لانه زيادة وصف بمنزلة زيادة وصف الجودة - وما يكون مقصودا بالوزن تنعدم به المماثلة ولا يكون ذلك من الجرحان في شئ وعلى هذا قلنا في العلل في الاحكام: إن ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح للترجيح به وإنما يكون الترجيح بمالا يصلح علة موجبة للحكم.
وبيان ذلك في الشهادات، فإن أحد المدعيين لو أقام شاهدين وأقام الاخر أربعة من الشهود لم يترجح الذى شهد له أربعة لان زيادة الشهادين في حقه علة تامة للحكم فلا يصلح مرجحا للحجة في جانبه، وكذلك زيادة شاهد واحد لاحد المدعيين، لانه من جنس ما تقوم به الحجة إصلا فلا يقع الترجيح به إصلا وإنما يقع الترجيح بما يقوى ركن الحجة أو يقوى معنى الصدق في الشهادگة وذلك فى أن تتعارض شهادة المستور مع شهادة العدل بأن أقام أحد المدعيين مستورين والاخر عدلين، فإنه يترجح الذى شهد به العدلان بظهور ما يؤكد معنى الصدق في شهادة شهوده.
وكذلك في النسب أو النكاح لو ترجح حجة أحد الخصمين باتصال القضاء بها، لان ذلك مما يؤكد ركن الحجة، فإن بقضاء القاضى يتم معنى الحجة في الشهادة ويتعين جانب الصدق - وعل يهذا قلنا في العلتين إذا تعارضتا لاتترجح إحداهما بانضمام علة إخرى إليها، وإنما تترجح بقوة الاثر فيها، فبه يتأكد ما هو الركن في صحة العلة.
وكذلك الخبران إذا تعارضا لا يترجح أحدهما على الاخر بل بما به يتأكد معنى الحجة
فيه وهو الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرجح المشهور بكثرة رواته على الشاذ لظهور زيادة القوة فيه من حيث الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترجح بفقه الراوى وحسن ضبطه وإتقانه، لانه يتقوى به معنى الاتصال برسول الله على الوجه الذى وصل إلينا بالنقل.
وكذلك
الايتان إذا وقعت المعارضة بينهما لاتترجح إحداهما بآية أخرى بل تترجح بقوة في معنى الحجة وهو أنه نص مفسر والاخر مؤول وكذلك لا يترجح أحد الخبرين بالقياس.
فعرفنا أن ما يقع به الترجيح هو مالا يصلح علة للحكم ابتداء، بل ما يكون مقويا لما به صارت العلة موجبة للحكم.
وعلى هذا قلنا لو أن رجلا جرح رجلا جراحة وجرحه آخر عشر جراحات فمات من ذلك فإن الدية عليهما نصفان.
لان كل جراحة علة تامة ولا يترجح أحدهما بزيادة عدد في العلة في جانبه حته يصير القتل مضافا إليه دون صاحبه بل يصير مضافا إلى فعلهما على وجوه التساوى.
ولو قطع أحدهما يده ثم جز الاخر رقبته فالقاتل هو الذى جز رقبته دون الاخر لزيادة قوة فيما هو علة القتل من فعله وهو أنه لا يتوهم بقاؤه حيا بعد فعله بخلاف فعل الاخر.
وعلى هذا الاصل رجحنا سبب استحقاق الشفعة للشريك في نفس المبيع على السبب في حق الشريك في حقوق المبيع، ثم رجحنا الشريك في حقوق المبيع على الجار لزيادة وكادة في الاتصال الذى ثبت بالجوار، فإن اتصال الملكين في حق الشريك في نفس المبيع في كل جزء في حق الشريك في حقوق المبيع الاتصال فيما هو بيع من المبيع، وفى حق الجار لا اتصال من حيث الاختلاط فيما هو مقصود ولا فيما هو تبع وإنما الاتصال من حيث المجاورة بين الملكين مع تميز أحدهما من الاخر، ثم من كان جواره من ثلاث جوانب لا يترجح عل يمن كان جواره من جانب واحد لان الموجود في جانبه زيادة العلة من حيث العدد فلا يثبت به الترجيح.
وعلى هذا قلنا: صاحب القليل يساوى صاحب الكثير في استحقاق الشقص المبيع بالشفعة، لان الشركة بكل جزء علة تامة لاستحقاق جميع الشقص المبيع بالشفعة، فإنما وجد في جانب صاحب الكثير كثرة العلة وبه لا يقع الترجيح.
وهكذا يقول الشافعي في اعتبار أصل الترجيح، فإنه لا يجرح
صاحب الكثير هنا حتى يكون لصاحب القليل حق المزاحمة معه في الاخذ بالشفعة، إلا أنه يجعل الشفعة من جملة مرافق الملك فتكون مقسومة بين الشفعاء على قدر الملك، كالولد والربح والثمار من الاشجار المشتركة، أو يجعل هذا بمنزلة ملك المبيع فيجعله مقسوما على مقدار ما يلتزم كل واحد من المشترين من بدله وهو الثمن، حتى إذا باع عبدا بثلاثة آلاف درهم من رجلين على أن يكون على أحدهما ألف درهم وعلى الآخر بعينه ألفا درهم فإن الملك بينهما في المبيع يكون أثلاثا على قدر الملك.
وهذا غلط منه لانه جعل الحكم مقسوما على قدر العلة، أو بنى العلة على الحكم، وذلك غير مستقيم.
وعلى هذا اتفقت الصحابة في امرأة ماتت عن ابني عم أحدهما زوجها، فإن للزوج النصف والباقي بنيهما العصوبة ولا يترجح الزوج بسبب الزوجية لان ذلك علة أخرى لاستحقاق الميراث سوى ما يستحق به العصوبة، فلا تترجح علته بعلة أخرى ولكن يعتبر كل واحد من السببين في حق من اجتمع في حقه السببان بمنزلة ما لو وجد كل واحد منهما في شخص آخر.
وكذلك قال أكثر الصحابة في ابني عم أحدهما أخ لام إنه لا يترجح بالاخوة لام على الآخر ولكن له السدس بالفرضية، والباقي بينهما نصفان بالعصوبة.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يترجح ابن العم الذي هو أخ لام لان الكل قرابة فتقوى إحدى الجهتين بالجهة الاخرى بمنزلة أخوين أحدهما لاب وأم والآخر لاب.
وأخذنا بقول أكثر الصحابة، لان العصوبة المستحقة بكونه ابن عم مخالف للمستحق بالاخوة، ولهذا يكون استحقاق ابن العم العصوبة بعد استحقاق الاخ بدرجات، والترجيح بقرابة الام في استحقاق العصوبة إنما يكون عند اتحاد جهة العصوبة والاستواء في المنزلة، كما في حق الاخوان فحينئذ يقع الترجيح بقرابة الام لانه لا يستحق بها العصوبة ابتداء فيجوز
أن تتقوى بها علة العصوبة في جانب الاخ لاب وأم، إذ الترجيح يكون بعد المعارضة والمساواة، فأما قرابة الاخوة فهي ليست من جنس قرابة ابن العم حتى تتقوى بها العصوبة الثابتة لابن العم الذي هو أخ لام بل يكون هذا السبب بمنزلة الزوجية فتعتبر حال اجتماعهما في شخص واحد بحال انفراد كل واحد من السببين في شخص آخر.
وكثير من المسائل تخرج على ما تركنا من الاصل في هذا الفصل إذا تأملت.
فصل وما ينتهى إليه ما يقع به الترجيح في الحاصل أربعة: أحدها قوة الاثر، والثاني قوة الثبات على الحكم المشهود به، والثالث كثرة الاصول، والرابع عدم الحكم عند عدم العلة.
أما الوجه الاول فلان المعنى الذي به صار الوصف حجة الاثر، فمهما كان الاثر أقوى كان الاحتجاج به أولى لصفة الوكادة فيما به صار حجة.
فذلك نحو دليل الاستحسان مع القياس، ونحو الاخبار إذا تعارضت، فإن الخبر لما كان حجة لمعنى الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يزيد معنى الاتصال وكادة من الاشتهار، وفقه الراوي وحسن ضبطه واتقانه كان الاحتجاج به أولى.
فإن قيل: أليس أن الشهادات متى تعارضت لم يترجح بعضها بقوة عدالة بعض الشاهد، وهي إنما صارت حجة باعتبار العدالة ثم بعد ظهور عادلة الفريقين لا يقع الترجيح بزيادة معنى العدالة ؟ قلنا: العدالة ليست بذي أنواع متفاوتة حتى يظهر لبعضها قوة عند المقابلة بالبعض، وهي عبارة عن التقوى والانزجار عن ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه، وذلك مما لا يمكن الوقوف فيه على حد أن يرجح البعض بزيادة قوة عند الرجوع إلى حده، بخلاف تأثير
العلة فإن قوة الاثر عند المقابلة تظهر على وجه لا يمكن إنكاره.
وبيان هذا في مسائل.
منها أن الشافعي علل في طول الحرة أنه يمنع نكاح الامة لان في هذا العقد إرقاق جزء منه مع استغنائه عنه، فلا يجوز كما لو كان تحته حرة، وهذا الوصف بين الاثر، فإن الارقاق نظير القتل من وجه، ألا نرى أن الامام في الاسارى يتخير بين القتل والاسترقاق ؟ فكما يحرم عليه قتل ولده شرعا يحرم عليه إرقاقه مع استغنائه عنه.
وقلنا: هذا النكاح يجوز لعبد المسلم، فإن المولى إذا دفع إليه مالا وأذن له في أن ينكح به ما شاء من حرة أو أمة جاز له أن ينكح الامة، فلما كان طول الحرة لا يمنع نكاح الامة للعبد المسلم لا يمنع للحر لوجود الحرة في الدنيا.
وتأثير ما قلنا أن تأثير الرق
في تنصيف الحل الذى يترتب عليه عقد النكاح وحقيقة التنصيف في أن يكون حكم العبد في النصف الباقي له وحكم الحر في جميع ذلك سواء فما يكون شرطا في حق الحر يكون شرطا في حق العبد كالشهود وخلو المرأة عن العدة، وما لا يكون شرطا في حق العبد لا يكون شرطا في حق الحر كالخطبة وتسمية المهر لا يكون في حق العبد.
ثم تظهر قوة التأثير لما قلنا في الرجوع إلى الاصول، فإن الرق من أوصاف النقصان والحرية من أوصاف الكمال، وهذا لاحل كرامة يختص به البشر فكيف يجوز القول بأنه يتسع الحل بسبب الرق حتى يحل للعبد ما لا يحل للحر.
وبزداد قوة بالنظر في أحوال البشر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أمته بزيادة اتساع في حله حتى جاز له نكاح تسع نسوة أو إلى ما لا يتناهى على حسب ما اختفوا فيه.
فتبين بهذا تحقيق معنى الكرامة في زيادة الحل وظهر أنه لا يجوم القول بزيادة حل العبد على حل الحر.
ويظهر ضعف أثر علته في الرجوع إلى الاصول، فإن
إرقاق الماء دون التضييع لا محالة، ويحل له أن يضيعماءه بالعزل عن الحرة بإذنها فلان يجوز تعريض ما به الرق بنكاح الامة كان أولى.
ويزداد ضعفا بالرجوع إلى أحوال البشر، فان من ملك نفسه على وجه يأمن أن يقع في الحرام يجوز له نكاح الامة ولا يحل له قتل ولده إذا أمن جانبه بحال من الاحوال.
وعلى هذا قلنا: للحر أن يتزوج أمة على أمة، لان ذلك جائز للعبد فيجوز للحر من الوجه الذى قررنا، ولا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة كما لا يجوز ذلك للحر، لان العبد في النصف الباقي له مثل الحر في الحكم.
وعلل في حرمة نكاح الامة الكتابية على المسلم بأنها أمة كافرة فلا يجوز نكاحها للمسلم كالمجوسة.
وهذا بين الاثر من وجهين: أحدهما أن الرق مؤثر في حرمة النكاح حتى لا يجوز نكاح الامة على الحرة.
والكفر كذلك، فإذا اجتمع الوصفان في شخص تغلظ معنى الحرمة فيها فيلتحق بالكفر المتغلظ بعدم الكتاب في المنع من النكاح.
والثانى أن جواز نكاح الامة بطريق الضرورة عند غشية العنت وهذه الضرورة ترتفع بحل الامة المسلمة فلا حاجة إلى حل الامة الكتابية للمسلم النكاح، وقلنا نحن: اليهودية
والنصرانية دين يجوز للمسلم نكاح الحرة من أهلها فيجوز نكاح الحرة من أهلها فيجوز نكاح الامة كدين الاسلام.
وتأثيره فيما بينا أن الرق يؤثر في التنصيف من الجانبين فيما يبتنى على الحل.
إلا أن ما يكون متعددا فالتنصيف يظهر في العدد كالطلاق والعمدة والقسم، والنكاح الذى يبتنى على الحل في جانب الرجل متعدد، فالتنصيف يظهر في العدد، وفى جانب المرأة غير متعدد فإنها لا تحل لرجلين بحال، ولكن من حيث الاحوال متعدد حال تقدم نكاحها على نكاح الحرة وحال التأخر وحال المقارنة، فيظهر التنصيف باعتبار الاحوال، وفى الحال الواحد يجتمع معنى الحل
ومعنى الحرمة فيترجح معنى الحرمة بمنزلة الطلاق والعدة فإن طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان، وفى الحقيقة هما حالتان: حالة الانفراد عن الحرة بالسبق وحالة الانضمام إلى الحرة بالمقارنة أو التأخر، فتكون محللة في إحدى الحالتين دون الاخرى ثم تظهر قوة هذا الاثر بالتأمل في الاصول، فإن الحل تارة يثبت بالنكاح وتارة بملك اليمين، ووجدنا أن الامة الكتابية كالامة المسلمة في الحل يملك اليمين فكذلك في الحل بانكاح، ولسنا نسلسم أنه يتغلظ كفر الكتابية برقها في حكم النكاح، فإنه لو كان كذلك لم يحل ببملك اليمين كالمجوسية.
ثم النقصان أو الخبث الثابت بكل واحد منهما من وجه سوى الوجه الاخر، و - نما يظهر التغليظ عند إمكان إثبات الاتحاد بينهما ومع اختلاف الجهة لا يتأتى ذلم، وقد بينا أن انضمام علة إلى علة ل يوجب قوة في الحكم ولا نسلم أن إباحة نكاح الامة بطريق الضرورة لما بينا أن الرقيق في النصف الباقي مساو للحر، فكما أن نكاح الحرة يكون أصلا مشروعا لا بطريق الضرورة فكذلك نكاح الامة في النصف الباقي لها، ونعتبرها بالعبد بل إولى لان معنى عدم الضرورة في حق الامة أضهر منه في حق العبد فإنها تستمع بمولاها بملك اليمين.
والعبد لا طريق له سوى ؟ ؟ ؟ ؟ ثم لم بجعل بقاء ما بقى في حق العبد بعد التنصيف بالرق ثابتا بطريق الضرورة
ففي حق الامة أولى.
وعلل الشافعي رحمه الله فيما إذا أسلم أحد الزوجين في دار الاسلام أو في دار الحرب، فإن كان قبل الدخول يتعجل الفرقة، وإن كان بعد الدخول يتوقف على انقضاء العدة، فإن الحادث اختلاف الدين بين الزوجين فيوجب الفرقة عند عدم العدة كالردة، وسوى بينهما في الجواب فقال: إذا ارتد أحدهما قبل الدخول تتعجل الفرقة في الحال، وبعد الدخول يتوقف
على انقضاء ثلاث حيض.
وبيان أثر هذا الوصف في ابتداء النكاح، فإن مع اختلاف الدين عند إسلام المرأة وكفر الزوج لا ينعقد النكاح ابتداء، كما أن عند ردة أحدهما لا ينعقد النكاح ابتداء، فكذلك في حالة البقاء تستوي ردة أحدهما وإسلام أحدهما إذا كان على وجه يمنع ابتداء النكاح، وفي الردة إنما يثبت هذا الحكم للاختلاف في الدين لا لمنافاة الردة النكاح فإنهما لو ارتدا معا - نعوذ بالله - لا تقع الفرقة بينهما، وإنما انعدم الاختلاف في الدين هنا، فأما الردة فمتحققة، ومع تحقق المنافي لا يتصور بقاء النكاح كالمحرمية بالرضاع والمصاهرة.
وقلنا نحن: الاسلام سبب لعصمة الملك، فلا يجوز أن يستحق به زوال الملك بحال، وكفر الذي أصر منهما على الكفر كان موجودا وصح معه النكاح ابتداء وبقاء، فلا يجوز أن يكون سببا للفرقة أيضا.
ولا يقال هذا الكفر إنما لم يكن سببا للفرقة في حال كفر الآخر لا بعد إسلامه، كما لا يكون سببا للمنع من ابتداء النكاح في حال كفر الآخر لا بعد إسلامه، لان اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جدا، فإن قيام العدة وعدم الشهود يمنع ابتداء النكاح، ولا يمنع البقاء والاستغناء عن نكاح الامة بنكاح الحرة يمنع نكاحها ابتداء ولا يمنع البقاء، إذا تزوج الحرة بعد الامة، فإن ظهر أن واحدا من هذين السببين لا يصلح سببا لاستحقاق الفرقة ولا بد من دفع ضرر الظلم المتعلق عنها، لان ما هو المقصود بالنكاح وهو الاستمتاع فائت شرعا، جعلنا السبب تفريق القاضي بعد عرض الاسلام على الذي يأبى منهما، وهو قوي الاثر بالرجوع إلى الاصول، فإن التفريق باللعان وبسبب الجب والعنة وبسبب الايلاء يكون ثابتا باعتبار هذا المعنى محالا به على من كان فوات الامساك بالمعروف من جهته،
فهنا أيضا يحال به على من كان فوات الامساك بالمعروف بالاصرار على الكفر من جهته، ولا يثبت إلا بقضاء القاضي.
فأما الردة فهي غير موضوعة للفرقة بدليل صحتها حيث لا نكاح وبه فارق الطلاق، وإذا لم يكن موضوعا للفرقة عرفنا أن حصول الفرقة بها لكونها منافية للنكاح حكما وذلك وصف مؤثر، فإن النكاح يبتنى على الحل الذي هو كرامة، وبعد الردة لا يبقى الحل، لان الردة سبب لاسقاط ما هو كرامة، ولازالة الولاية والمالكية الثابتة بطريق الكرامة، فجعلها منافية للنكاح حكما يكون قوي الاثر من هذا الوجه، ومع وجود المنافي لا يبقى النكاح سواء دخل بها أو لم يدخل.
فأما إذا ارتدا معا فحكم بقاء النكاح بينهما معلوم بإجماع الصحابة بخلاف القياس، وقد بينا أن المعدول به عن القياس بالنص أو بالاجماع لا يشتغل فيه بالتعليل ولا بإثبات الحكم فيه بعلة، وقد بينا فساد اعتبار حالة البقاء بحالة الابتداء، فلا يجوز أن يجعل امتناع صحة النكاح بينهما ابتداء بعد الردة علة للمنع من بقاء النكاح، وهذا لان البقاء لا يستدعي دليلا مبقيا، وإنما يستدعي الفائدة في الابقاء، وبعد ردتهما نعوذ بالله يتوهم منهما الرجوع إلى الاسلام وبه تظهر فائدة البقاء.
فأما الثبوت ابتداء يستدعي الحل في المحل وذلك منعدم بعد الردة، وعند ردة أحدهما لا يظهر في الابقاء فائدة مع ما هما عليه من الاختلاف.
وعلى هذا علل الشافعي رحمه الله في عدد الطلاق فإنه معتبر بحال الزوج لانه هو المالك للطلاق وعدد الملك معتبر بحال المالك كعدد النكاح، وهذا بين الاثر، لان المالكية عبارة عن القدرة والتمكن من التصرف، فإذا كان الزوج هو المتمكن من التصرف في الطلاق بالايقاع عرفنا أنه هو المالك له، وإنما يتم الملك باعتبار كمال حال المالك بالحرية كما أن ملك التصرف بالاعتاق وغيره إنما يتم بكمال حال المالك بالحرية.
وقلنا نحن: الطلاق تصرف بملك بالنكاح فيتقدر بقدر ملك النكاح وذلك يختلف باختلاف حال المرأة في الرق والحرية، لان الملك إنما يثبت في المحل
باعتبار صفة الحل، والحل الذي يبتنى عليه النكاح في حق الامة على النصف منه في حق الحرة فبقدر ذلك يثبت الملك، ثم بقدر الملك يتمكن المالك من الابطال، كما أن بقدر ملك اليمين يتمكن من إبطاله بالعتق، حتى إنه إذا كان له عبد واحد يملك إعتاقا واحدا، فإن كان له عبدان يملك عتقين.
ثم ظهر قوة الاثر لما قلنا بالرجوع إلى الاصل وهو أن ما يبتنى على ملك النكاح ويختص به فإنه يختلف باختلاف حالها، وذلك نحو القسم في حال قيام النكاح والعدة وحق المراجعة باعتبارها بعد الطلاق، فعرفنا أنه يتقدر ما يبتنى على ملك النكاح بقدر الملك الثابت بحسب ما يسع المحل له.
وعلى هذا علل في تكرار المسح بأنه ركن في الوضوء فيسن فيه التكرار كالغسل.
وقلنا نحن: إنه مسح فلا يسن فيه التكرار كالمسح بالخف، ثم كان تأثير المسح في إسقاط التكرار أقوى من تأثير الركنية في سنة التكرار فيه، فإن التكرار مشروع في المضمضة والاستنشاق وليسا بركن، وتأثير المسح في التخفيف فإن الاكتفاء بالمسح فيه مع إمكان الغسل ما كان إلا للتخفيف، وعند الرجوع إلى الاصول يظهر معنى التخفيف بترك التكرار بعد الاكمال مع ما فيه من دفع الضرر الذي يلحقه بإفساد عمامته بكثرة ما يصيب رأسه من البلة.
وعلى هذا علل في اشتراط تعيين النية في الصوم بأنه صوم فرض، وهو بين الاثر، فإن اشتراط النية لمعنى التقرب وصفة الفرضية قربة كالاصل.
وقلنا نحن: صوم عين، وتأثيره أن اشتراط النية، في العبادة في الاصل للتمييز بين أنواعها بتعين نوع منها، وهذا متعين شرعا فلا معنى لاشتراط
النية للتعيين، ومعنى القربة يتم بوجود أصل النية، فباعتبار قوة الاثر من هذا الوجه يظهر الترجيح.
وما يخرج على هذا من المسائل لا يحصى وفيما ذكرنا كفاية لمن يحسن التأمل في نظائرها.
وأما الوجه الثاني وهو الترجيح بقوة ثبات الحكم المشهود به فلان أصل ذلك إنما يكون عن نص أو إجماع، وما يكون ثبوته بالنص أو الاجماع يكون ثابتا متأكدا، فما يظهر فيه زيادة القوة في الثبات عند العرض على الاصول يكون راجحا باعتبار ما به صار حجة.
وبيان ذلك في مسألة
مسح الرأس أيضا، فإن الوصف الذي عللنا به له زيادة قوة الثبات على الحكم المشهود به، ألا ترى أن سائر أنواع المسح كالتيمم والمسح على الخف والمسح على الجورب عند من يجيزه والمسح على الجبائر يظهر الخفة فيها بترك اعتبار التكرار، وليس للوصف الذي علل به قوة الثبات بهذه الصفة، فإن في الصلاة أركانا كالقيام والقراءة والركوع والسجود، ثم تمامها يكون بالاكمال لا بالتكرار، فعرفنا أن الركنية ليس بوصف قوي ثابت في إثبات سنة التكرار به، وكذلك في الصوم، فإن صفة العينية قوي ثابت في إسقاط اشتراط نية التعيين فيه حتى يتعدى إلى سائر العبادات، كالزكاة إذا تصدق بالنصاب على الفقير وهو لا ينوي الزكاة، والحج إذا أطلق النية ولم يعين حجة الاسلام، والايمان بالله تعالى.
ويتعدى إلى غير العبادات نحو رد الودائع والغصوب ورد المبيع على البائع لفساد البيع.
وصفة الفرضية ليس بقوي ثابت في اشتراط نية التعيين بعدما صار متعينا في الصوم لا في غير الصوم.
وكذلك ما علل به علماؤنا في أن المنافع لا تضمن بالاتلاف لان ضمان المتلفات مقدر بالمثل بالنص، وباعتبار ما هو المقصود وهو الجبران،
وبين العين والمنفعة تفاوت في المالية من الوجه الذي ذكرنا، فلا يجوز أن يوجب على المتلف فوق ما أتلف في صفة المالية، كما لا يوجب الجيد بإتلاف الردئ.
وقال الشافعي رحمه الله: المنافع تضمن بالعقد الجائز والفاسد بالدراهم فتضمن بالاتلاف كالاعيان، ثم تأثيره تحقق الحاجة إلى التحرر عن إهدار حق المتلف عليه، فإنه نظير تحقق الحاجة إلى ملك المنفعة بالعوض بالعقد.
ثم هو يزعم أن علته أقوى في ثبات الحكم المشهود به عليه من وجهين: أحدهما أنه إذا لم يكن بد من الاضرار بأحدهما فمراعاة جانب المظلوم وإلحاق الخسران بالظالم بإيجاب الزيادة عليه أولى من إهدار حق المظلوم.
والثاني أن في إيجاب الضمان إهدار حق الظالم فيما هو وصف محض وهو صفة البقاء، وفي الاصل هما شيئان وهو كونهما منتفعا به، غير أن في طرف الظالم فضل صفة وهو البقاء، فبهدر صيانة الاصل (هدر) حق المظلوم.
وإذا قلنا: لا يجب الضمان كان فيه إهدار حق المتلف عليه في أصل المالية، ولا شك أن الوصف دون الاصل.
ونحن نقول: قوة ثبات الحكم فيما اعتبرناه، لان في إيجاب الزيادة معنى الجور، ولا يجوز نسبة ذلك إلى الشرع بغير واسطة من العباد بحال من الاحوال، وإذا لم نوجب الضمان فإنما لا نوجب لعجزنا عن إيجاب المثل في موضع ثبت اشتراط المماثلة فيه بالنص، وبه فارق ضمان العقد، فإنه غير مبني على المماثلة بأصل الوضع، وكيف يكون مبنيا على ذلك والمبتغي به الربح والامتناع من الاقدام عند تحقق العجز أصل مشروع لنا ؟ والثاني أن في إيجاب الزيادة إهدار حق المتلف في هذه الزيادة في الدنيا والآخرة.
وإذا قلنا: لا يجب الضمان لا يهدر حق المتلف عليه أصلا بل يتأخر إلى الآخرة وضرر التأخير دون ضرر الاهدار.
ولا يدخل على هذا
إتلاف ما لا مثل له من جنسه، لان الواجب هو مثل المتلف في المالية شرعا إلا أنه آل الامر إلى الاستيفاء وذلك يبتنى على الوسع.
قلنا يتقدر بقدر الوسع ويسقط اعتبار أدنى تفاوت في القيمة، لانه لا يستطاع التحرز عن ذلك ولكن لا يتحقق في هذا معنى نسبة الجور إلى الشرع، فالواجب شرعا هو المثل لا غير، وما اعتبر من ترجيح جانب المظلوم فهو ضعيف جدا، لان الظالم لا يظلم ولكن ينتصف منه مع قيام حقه في ملكه، فلو لم نوجب الضمان لسقط حق المظلوم لا بفعل مضاف إلينا، وعند ايجاب الضمان يسقط حق الظالم في الوصف بمعنى مضاف الينا وهو أنا نلزمه أداء ذلك بطريق الحكم به عليه، ومراعاة الوصف في الوجوب كمراعاة الاصل، ألا ترى أن في القصاص الذي يبتنى على المساواة التفاوت في الوصف كالصحيحة مع الشلاء يمنع جريان القصاص، ولا ينظر إلى ترجيح جانب المظلوم وإلى ترجيح جانب الاصل على الوصف، فعرفنا أن قوة الثبات فيما قلنا.
وعلى هذا قلنا: إن ملك النكاح لا يضمن بالاتلاف في الشهادة على الطلاق قبل الدخول، وملك القصاص لا يضمن بالاتلاف في الشهادة على العفو، وقد بينا فيما سبق أن وجوب الدية عند إتلاف النفس أو الاطراف على وجه لا يمكن إيجاب المثل فيه حكم ثابت بالنص بخلاف القياس وهو لصيانة المحل عن
الاهدار لا للماثلة على وجه الخبران، لان النفوس بأطرافها مصونة عن الابتذال وعن الاهدار.
وأما الوجه الثالث: وهو الترجيح بكثرة الاصول فلان كثرة الاصول في المعنى الذي صار الوصف به حجة بمنزلة الاشتهار في المعنى الذي صار الخبر به حجة، وهذا يظهر إذا تأملت فيما ذكرنا من المسائل وغيرها،
وما من نوع من هذه الانواع الثلاثة إذا قررته في مسألة إلا وتبين به إمكان تقرير النوعين الآخرين فيه أيضا.
وأما الوجه الرابع: وهو الترجيح بعدم الحكم عند عدم العلة فهو أضعف وجوه الترجيح، لما بينا أن العدم (لا يوجب شيئا، وأن العدم لا يكون متعلقا بعلة، ولكن انعدام الحكم عند انعدام العلة) يصلح أن يكون دليلا على وكادة اتصال الحكم بالعلة، فمن هذا الوجه يصلح للترجيح.
وبيانه في المسح بالرأس أيضا، فإن التعليل بأنه ركن لا يكون في القوة كالتعليل بأنه مسح، لان حكم ثبوت التكرار لا ينعدم بانعدام الركنية كما في المضمضة والاستنشاق، وحكم سقوط التكرار ينعدم بانعدام وصف المسح كما في اغتسال الجنب والحائض، فإنه يسن فيه صفة التكرار لانه ليس بمسح.
وكذلك في كل ما يعقل تطهيرا صفة التكرار فيه يكون مسنونا، وفيما لا يعقل تطهيرا لا يسن فيه صفة التكرار، وقولنا مسح ينبئ عن ذلك.
وكذلك قلنا في الاخ إذا ملك أخته إن بينهما قرابة محرمة للنكاح، وينعدم حكم العتق بالملك عند انعدام هذا المعنى كما في بني الاعمام، وهو إذا قال شخصان يجوز لاحدهما أن يضع زكاة ماله في صاحبه فلا يعتق أحدهما على صاحبه إذا ملكه لانعدام هذا الحكم عند انعدام هذا المعنى، فإن المسلم لا يجوز له أن يضع زكاة ماله في الكافر، وذلك لا يدل على أنه يعتق أحدهما على صاحبه إذا ملكه.
وكذلك قلنا في بيع الطعام بالطعام إنه لا يشترط قبضه في المجلس لانه عين بعين، وينعدم هذا الحكم عند انعدام
هذا الوصف، فإنه في باب الصرف يشترط القبض من الجانبين، لان الاصل فيه النقود وهي لا تتعين في العقود فكان دينا بدين، وفي السلم يشترط
القبض في رأس المال، لان المسلم فيه دين ورأس المال في الغالب نقد فيكون دينا بدين، فعرفنا أنه ينعدم الحكم عند انعدام العلة.
وهو يعلل فيقول: مالان لو قوبل كل واحد منهما بجنسه يحرم التفاضل بينهما فيشترط التقابض في بيع أحدهما بالآخر كالذهب والفضة.
ثم الحكم لا ينعدم عند انعدام هذا المعنى في السلم، فإنه يشترط قبض رأس المال في المجلس، وإن جمع العقد هناك بدلين لا يحرم التفاضل إذا قوبل كل واحد منهما بجنسه.
فهذا بيان الفصل الرابع.
فصل وأما المخلص من التعارض في دليل الترجيح فطريق بيانه أن نقول: إن كل محدث موجود بصورته ومعناه الذي هو حقيقة له، ثم تقوم به أحوال تحدث عليه، فإذا قام دليل الترجيح لمعنى في ذات أحد المتعارضين وعارضه دليل الترجيح لمعنى في حال الآخر على مخالفة الاول فإنه يرجح المعنى الذي هو في الذات على المعنى الذي هو في الحال لوجهين: أحدهما أن الذات أسبق وجودا من الحال، فبعدما وقع الترجيح لمعنى فيه لا يتغير بما حدث من معنى في حال الآخر بعد ذلك، بمنزلة ما لو اتصل الحكم باجتهاد فتأيد به ثم لم ينسخ بما يحدث من اجتهاد آخر بعد ذلك، وإذا اتصل الحكم بشهادة المستورين بالنسب أو النكاح لرجل لم يتغير بعد ذلك بشهادة عدلين لآخر.
والثاني أن الاحوال التي تحدث على الذات تقوم به فكان الذات بمنزلة الاصل وما يقوم به من الحال بمنزلة التبع، والاصل لا يتغير بالتبع على أي وجه كان.
وبيان هذا فيما اتفقوا عليه أن ابن الاخ لاب وأم يكون مقدما في العصوبة على العم، لان المرجح فيه معنى في ذات
القرابة وهو الاخوة التي هي مقدمة على العمومة، وفي العم المرجح هو زيادة القرب باعتبار الحال.
وكذلك العمة لام مع الخالة لاب وأم إذا اجتمعتا فللعمة الثلثان، باعتبار أن المرجح في حقها هو معنى في ذات القرابة وهو الادلاء بالاب، وفي الاخرى معنى في حالها وهو اتصالها من الجانبين بأم الميت.
ولو كانا أخوين أحدهما لاب وأم والآخر لاب فإنه يقدم في العصوبة الذي لاب وأم، لانهما استويا في ذات القرابة فيصار إلى الترجيح باعتبار الحال وهو زيادة الاتصال لاحدهما.
ولو كان ابن الاخ لاب معه ابن ابن أخ لاب وأم فإن الاخ لاب يقدم في العصوبة، باعتبار الحال لما استويا في ذات القرابة وهو الاخوة.
وربما خفي على الشافعي هذا الحد في بعض المسائل فهو معذور لكونه خفيا، ومن أصاب مركز الدليل فهو مأجور مشكور.
وبيانه في مسائل الغصب فإن علماءنا أثبتوا الترجيح باعتبار الصناعة والخياطة والطبخ والشي، وقالوا فيمن غصب ساحة وأدخلها في بنائه ينقطع حق المغصوب منه عن الساحة، لان الصنعة التي أحدثها الغاصب فيها قائمة من كل وجه غير مضاف إلى صاحب العين، وعين الساحة قائم من وجه مستهلك من وجه، لانه صار مضافا إلى الحادث بعمل الغاصب وهو البناء، فرجحنا ما هو قائم من كل وجه باعتبار معنى في الذات، وأسقطنا اعتبار معنى قوة الحال في الجانب الآخر وهو أنه أصل، وفي الساحة إذا بنى عليها لما استويا في أن كل واحد منهما قائم من كل وجه، فرجحنا باعتبار الحال حق صاحب الساحة على حق صاحب البناء (لان قوام البناء) للحال بالساحة وقوام الساحة ليس بالبناء.
وكذلك الثوب إذا قطعه وخاطه، واللحم إذا طبخه أو شواه، لان الوصف الحادث بعمل الغاصب قائم من كل وجه، وما هو حق المغصوب منه قائم من وجه مستهلك
من وجه باعتبار العمل المضاف إلى الغاصب، فيترجح ما هو قائم من كل وجه.
وكذلك قلنا صوم رمضان يتأدى بالنية الموجودة في أكثر النهار لان الامساك
في جميع النهار ركن واحد، وشرط كونه صوما شرعيا النية ليحصل بها الاخلاص، فإذا ترجح جانب الوجود باقتران النية بأكثر هذا الركن قلنا يحصل به امتثال الامر.
ف الشافعي يقول: يؤخذ في العبادات بالاحتياط، فإذا انعدمت النية في جزء من هذا الركن يترجح جانب العدم على جانب الوجود لاجل الاحتياط في أداء الفريضة، فكان ما اعتبره معنى في الحال وهو أنه فرض يؤخذ فيه بالاحتياط، وما اعتبرناه معنى في الذات، والمرجح في الذات أولى بالاعتبار من المرجح في الحال.
وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل مائتا درهم وخمس من الابل السائمة فسبق حول السائمة فأدى عنها شاة ثم باعها بمائتي درهم فإنه لا يضم ثمنها إلى ما عنده ولكن ينعقد على الثمن حول جديد، فلو استفاد مائتي درهم بهبة أو ميراث فإنه يضمها إلى أقرب المالين في الحول، وإن كان المستفاد ربح أحد المالين أو زيادة متولدة من عين أحد المالين يضم ذلك إلى الاصل، وإن كان أبعد في الحول لان المرجح هنا معنى في الذات وهو كونه نماء أحد المالين فيسقط بمقابلته اعتبار الحال في المال الآخر وهو القرب في الحول، وفي الاول لما استوى الجانبان فيما يرجع إلى الذات صرنا إلى الترجيح باعتبار الحال.
والمسائل على هذا الاصل يكثر تعدادها، والله أعلم.
فصل وأما الفاسد من الترجيح فأنواع أربعة: أحدها ما بينا من ترجيح قياس بقياس آخر، لان كل واحد منهما علة شرعية لثبوت الحكم بها فلا تكون إحداهما مرجحة للاخرى بمنزلة زيادة العدد في الشهود.
وكذلك ترجيح أحد
القياسين بالخبر فاسد، لان القياس متروك بالخبر فلا يكون حجة في مقابلته والمصير إلى الترجيح بعد وقوع التعارض باعتبار المماثلة كما بينا.
وكذلك ترجيح أحد الخبرين بنص الكتاب فاسد، لان الخبر لا يكون حجة في معارضة النص.
والنوع الثاني الترجيح بكثرة الاشباه فإنه فاسد عندنا.
وبيانه فيما يقوله الخصم: إن الاخ يشبه الاب من وجه وهو المحرمية ويشبه ابن العم من وجوه نحو جريان القصاص من الطرفين، وقبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه،
وجواز وضع الزكاة لكل واحد منهما في صاحبه، وحل حليلة كل واحد منهما لصاحبه وغير ذلك من الاحكام.
قالوا: فيرجح باعتبار كثرة الاشباه، وهو فاسد عندنا لان الاصول شواهد، وقد بينا أن الترجيح بزيادة عدد الشهود في الخصومات فاسد، وفي الاحكام الترجيح بكثرة العلل فاسد، فكذلك الترجيح بكثرة الاشباه.
والنوع الثالث الترجيح بعموم العلة، وذلك نحو ما يقوله الخصم: إن تعليل حكم الربا في الاشياء الاربعة بالطعم أولى لانه يعم القليل والكثير، والتعليل بالقدر يخص الكثير وما يكون أعم فهو أولى.
وعندنا هذا فاسد، لان إثبات الحكم بالعلة فرع لاثبات الحكم بالنص، وعندنا الترجيح في النصوص لا يقع بالعموم والخصوص، وعنده الخاص يقضي على العام، كيف يقول في العلل إن ما يكون أعم فهو مرجح على ما يكون أخص، ثم معنى العموم والخصوص يبتنى على الصيغة، وذلك إنما يكون في النصوص، فأما العلل فالمعتبر فيها التأثير أو الاحالة على حسب ما اختلفا فيه، ولا مدخل للعموم والخصوص في ذلك.
والنوع الرابع الترجيح بقلة الاوصاف، وذلك نحو ما يقوله الخصم في أن ما جعلته علة في باب الربا وصف واحد وهو الطعم، فأما الجنسية عندي شرط
وأنتم تجعلون علة الربا ذات وصفين، فتترجح علتي باعتبار قلة الاوصاف.
وهذا فاسد عندنا لما بينا أن ثبوت الحكم بالعلة فرع لثبوته بالنص، والنص الذي فيه بعض الايجاز والاختصار لا يترجح على ما فيه بعض الاشباع في البيان فكذلك العلة بل أولى، لان ثبوت الحكم هناك بصيغة النص الذي يتحقق فيه الاختصار والاشباع، وهنا باعتبار المعنى المؤثر ولا يتحقق فيه الايجاز والاشباع.
باب: وجوه الاعتراض على العلل الطردية التي يجوز الاحتجاج بها هذه الوجوه أربعة: القول بموجب العلة، ثم الممانعة، ثم بيان فساد الوضع، ثم النقض.
فنقدم بيان القول بموجب العلة لان المصير إلى المنازعة عند تعذر إمكان الموافقة، وأما مع إمكان الموافقة وتحصيل المقصود به فلا معنى للمصير إلى المنازعة.
ثم تفسير القول بموجب العلة هو التزام ما رام المعلل التزامه بتعليله.
وبيان ذلك فيما علل به الشافعي رحمه الله في تكرار المسح بالرأس أنه ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالغسل في المغسول، لانا نقول بموجب هذا.
فنقول: يسن تثليثه وتربيعه أيضا، لان المفروض هو المسح بربع الرأس عندنا، وعنده أدنى ما يتناوله الاسم، ثم استيعاب جميع الرأس بالمسح سنة، وبالاستيعاب يحصل التثليث والتربيع ولكن في محل غير المحل الذي قام فيه الفرض، لانه لا فرق بين أن يكون تثليث الفعل في محل أو محال، فإن من دخل ثلاث أدور يقول دخلت ثلاث دخلات، كما أن من دخل دارا واحدة ثلاث مرات يقول دخلت ثلاث دخلات، فإن غير الحكم فقال وجب أن يسن تكراره.
قلنا: الآن هذا في الاصل ممنوع، فإن المسنون في
الغسل ليس هو التكرار مقصودا عندنا بل الاكمال، وذلك بالزيادة على الفريضة إلا أن هناك الاستيعاب فرض، فالزيادة بعد ذلك الاكمال لا يكون إلا بالتكرار، فكان وقوع التكرار فيه اتفاقا لا أن يكون مقصودا، وهنا الاستيعاب ليس بفرض فيحصل الاكمال فيه بالاستيعاب لوجود الزيادة على القدر المفروض، والاكمال يحصل به في الاركان نحو القراءة في الصلاة، فالاكمال يكون فيه بالاطالة لا بالتكرار، وكذلك الاكمال في الركوع والسجود، ولان الاكمال فيما يعقل فيه المعنى وهو التطهير بتسييل الماء على العضو إنما يكون بالتكرار كما في غسل النجاسة العينية عن البدن أو الثوب يكون الاكمال فيه بالتكرار إلى طمأنينة القلب، فأما في المسح الذي لا يعقل فيه معنى التطهير لا يكون
للتكرار فيه تأثير في الاكمال، بل الاكمال فيه يكون بالاستيعاب الذي فيه زيادة على القدر المفروض، وعند ذلك يضطر المعلل إلى الرجوع إلى طلب التأثير بوصف الركنية ووصف المسح الذي تدور عليه المسألة، ثم يظهر تأثير المسح في التخفيف، وتحقيق معنى الاكمال فيه بالاستيعاب كما في المسح بالخف، ويتبين أنه لا أثر للركنية في اشتراط التكرار، فإن التكرار مسنون في المضمضة والاستنشاق مع انعدام الركنية، ويتبين أن ما يكون ركنا وما يكون سنة وما يكون أصلا وما يكون رخصة في معنى الاكمال بالزيادة على القدر المفروض سواء، ثم في المسح الذي هو رخصة لما لم يكن الاستيعاب ركنا كالمسح بالخف كان الاكمال فيه بالاستيعاب لا بالتكرار، وكذلك في المسح الذي هو أصل، وفيما يكون مسنونا لما كان إقامة أصل السنة فيه بالاستيعاب كان الاكمال فيه بالتكرار كالمضمضة، وكذلك فيما هو ركن إذا كان إقامة الفرض لا تحصل إلا بالاستيعاب كان الاكمال فيه بالتكرار، فيظهر فقه المسألة من هذا الوجه.
ومن ذلك ما علل به الشافعي في صوم التطوع إنه باشر فعل قربة لا يمضي في فاسدها فلا يلزمه القضاء بالافساد، لانا نقول بموجب هذه العلة، فإن عندنا القضاء لا يجب بالافساد وإنما يجب بما وجب به الاداء وهو الشروع، فإن غير العبارة وقال وجب أن لا يلزم بالشروع كالوضوء.
قلنا: الشروع في العبادة باعتبار كونها مما لا يمضي في فاسدها لا يكون ملزما عندنا بل باعتبار كونها مما تلتزم بالنذر، وعدم اللزوم باعتبار الوصف الذي قاله لا يمنع اللزوم باعتبار الوصف الذي قلنا، ولا بد من إضافة الحكم إلى الوصف الذي هو ركن تعليله، فإن لم يجب باعتبار وصف لا يدل على أنه لا يجب باعتبار وصف آخر، وعند ذلك يضطر إلى إقامة الدليل على أن الشروع غير ملزم وأنه ليس نظير النذر في كونه ملزما، فتبين فقه المسألة.
ومن ذلك قولهم إسلام المروي في المروي جائز لانه أسلم مذروعا في مذروع فيجوز كإسلام الهروي بالمروي، لانا نقول بموجبه، فإن كونه مذروعا في مذروع لا يفسد العقد عندنا ولكن هذا الوصف لا يمنع فساد العقد باعتبار
معنى آخر هو مفسد، ألا ترى أنه يفسد بذكر شرط فاسد فيه وبترك قبض رأس المال في المجلس مع أنه أسلم مذروعا في مذروع.
فإذا جاز أن يفسد هذا العقد مع وجود هذا الوصف باعتبار معنى آخر بالاتفاق فلماذا لا يجوز أن يفسد باعتبار الجنسية، فيضطر عند ذلك إلى الشروع في فقه المسألة والاشتغال بأن الجنسية لا تصلح علة لفساد هذا العقد بها إن أمكنه ذلك.
ومن ذلك تعليلهم في الطلاق الرجعي إنها مطلقة فتكون محرمة الوطئ كالمبانة، لانا نقول بموجبه، فإنا لا نجعلها محللة الوطئ لكونها مطلقة بل لكونها منكوحة، وبالاتفاق مع كونها مطلقة إذا كانت منكوحة تكون محللة
الوطئ كما بعد المراجعة، فإن الطلاق الواقع بالرجعة لا يرتفع ولا تخرج من أن تكون مطلقة، فيضطر حينئذ إلى الرجوع إلى فقه المسألة، وهو أن وقوع الطلاق هل يمكن خللا في النكاح أو هل يكون محرما للوطئ مع قيام ملك النكاح، وعلى هذا يدور فقه المسألة.
ومن ذلك ما قالوا في المختلعة لا يلحقها الطلاق لانها ليست بمنكوحة، فإن عندنا باعتبار هذا الوصف لا يكون محلا لوقوع الطلاق عليها عند الايقاع، ولكن هذا لا يبقى وصفا آخر فيها يكون به محلا لوقوع الطلاق عليها، وهو ملك اليد الباقي له عليها ببقاء العدة، فيضطر بهذا إلى الرجوع إلى فقه المسألة.
ومن ذلك تعليلهم في إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار فإنه تحرير في تكفير فلا يتأدى بالرقبة الكافرة كما في كفارة القتل، لانا نقول بموجب هذا، فإن عندنا لا يتأدى الواجب من الكفارة بهذا الوصف الذي قال بل بوجود الامتثال منه للامر، كما يتأدى بصوم شهرين متتابعين، وبإطعام ستين مسكينا عند العجز عن الصوم، فيضطر عند ذلك إلى الرجوع إلى فقه المسألة، وهو أن الامتثال لا يحصل هنا بتحرير الرقبة الكافرة كما لا يحصل في كفارة القتل، لان المطلق محمول على المقيد.
ومن ذلك قولهم في الاخ إنه لا يعتق على أخيه إذا ملكه لانه ليس
بينهما جزئية، فإنا نقول بموجبه، فباعتبار انعدام الجزئية بينهما لا يثبت العتق عندنا، ولكن انعدام الجزئية لا ينفي وجود وصف آخر به تتم علة العتق وهو القرابة المحرمة للنكاح، فيضطر عند ذلك إلى الشروع في فقه المسألة، وهو أن القرابة المحرمة للنكاح هل تصلح متممة لعلة العتق مع الملك بدون الولاد أم لا.
وأكثر ما يذكر من العلل الطردية يأتي عليها هذا النوع من
الاعتراض، وهو طريق حسن لالجاء أصحاب الطرد إلى الشروع في فقه المسألة.
فصل: في الممانعة قال رضي الله عنه: الممانعة على هذا الطريق على أربعة أوجه: إحداها في الوصف، والثانية في صلاحية الوصف للحكم، والثالثة في الحكم، والرابعة في إضافة الحكم إلى الوصف، وهذا لان شرط صحة العلة عند أصحاب الطرد كون الوصف صالحا للحكم ظاهرا وتعليق الحكم به وجودا وعدما.
أما بيان النوع الاول فيما علل به الشافعي في الكفارة على من أفطر بالاكل والشرب قال: هذه عقوبة تتعلق بالجماع فلا تتعلق بغير الجماع كالرجم.
لانا لا نسلم أن الكفارة تتعلق بالجماع وإنما تتعلق بالافطار على وجه يكون جناية متكاملة، وعند هذا المنع يضطر إلى بيان حرف المسألة، وهو أن السبب الموجب للكفارة الفطر على وجه تتكامل به الجناية أو الجماع المعدم للصوم، وإذا ثبت أن السبب هو الفطر بهذه الصفة ظهر تقرر السبب عند الاكل والشرب وعند الجماع بصفة واحدة.
وبيان النوع الثاني في تكرار المسح بالرأس فإن الخصم إذا علل فقال: هذه طهارة مسح فيسن فيها التثليث كالاستنجاء بالاحجار.
قلنا: لا نسلم هذا الوصف في الاصل، فإن الاستنجاء إزالة النجاسة العينية، فأما أن يكون طهارة بالمسح فلا، ولهذا لو لم يتلوث شئ من ظاهر بدنه لا يكون عليه الاستنجاء، ولهذا كان الغسل بالماء أفضل.
ثم المسح الذي يدل على التخفيف لا يكون صالحا لتعليق حكم التثليث به، وبدون الصلاحية لا يصلح
التعليل، فيضطر عند هذا المنع إلى الرجوع إلى حرف المسألة وهو إثبات التسوية بين الممسوح والمغسول بوصف صالح لتعلق حكم التكرار به، أو التفرقة
بينهما بوصف المسح والغسل، فإن أحدهما يدل على الاستيعاب والآخر يدل على التخفيف بعين المسح.
وكذلك تعليلهم في بيع تفاحة بتفاحتين إنه باع مطعوما بمطعوم من جنسه مجازفة، فلا يجوز كبيع صبرة بصبرة من حنطة.
لانا نقول: يعني بهذا المجازفة ذاتا أم قدرا ؟ فلا يجد بدا من أن يقول ذاتا، فنقول: حينئذ يعني المجازفة في الذات صورة أم عيارا، فلا يجد بدا من أن يقول عيارا، لان المجازفة من حيث الصورة في الذات لا تمنع جواز البيع بالاتفاق، فإن بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة جائز مع وجود المجازفة في الذات صورة، فربما يكون أحدهما أكثر في عدد الحبات من الآخر.
وإذا ادعى المجازفة عيارا قلنا: هذا الوصف إنما يستقيم فيما يكون داخلا تحت المعيار والتفاح وما أشبهه لا يدخل تحت المعيار، فلا يكون هذا الوصف صالحا لهذا الحكم، ولان المساواة كيلا شرط جواز العقد في الاموال الربوية بالاجماع، ومن ضرورته أن يكون ضده وهو الفضل في المعيار مفسدا للعقد، والفضل في المعيار لا يتحقق فيما لا يدخل تحت المعيار، كما أن المساواة في المعيار الذي هو شرط الجواز عنده لا يتحقق فيما لا يدخل تحت المعيار، فيضطر عند هذا إلى بيان الحرف الذي تدور عليه المسألة، وهو أن حرمة العقد في هذه الاموال عند المقابلة بجنسها أصل، والجواز يتعلق بشرطين: المساواة في المعيار، واليد باليد.
وعندنا جواز العقد فيها أصل كما في سائر الاموال، والفساد باعتبار فضل هو حرام وهو الفضل في المعيار، وذلك لا يتحقق إلا فيما تتحقق فيه المساواة في المعيار، إذ الفضل يكون بعد تلك المساواة، ولا تتحقق هذه المساواة فيما لا يدخل تحت المعيار أصلا.
ومن ذلك تعليلهم في الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها لانها ثيب يرجى
مشورتها، فلا ينفذ العقد عليها بدون رأيها كالنائمة والمغمى عليها.
لانا نقول: ما تعنون بقولكم بدون رأيها ؟ رأي قائم في الحال أم رأي سيحدث أم أيهما كان ؟ فإن قالوا أيهما كان فهو باطل من الكلام، لان الثيب المجنونة تزوج في الحال، ورأيها غير مأنوس عنها لتوهم الافاقة، فلا نجد بدا من أن نقول المراد رأي قائم لها، وهذا ممنوع في الفرع، فإنه ليس لها رأي قائم في الحال في المنع ولا في الاطلاق، فإن من لم يجوز تزويجها لم يفصل في ذلك بين أن يكون العقد برأيها (وبدون رأيها) ومن جوز العقد فكذلك لم يفصل، فعرفنا أنه ليس لها رأي قائم، وما سيحدث من علة أو مانع لا يجوز أن يكون مؤثرا في الحكم قبل حدوثه، ومن جوز حدوثه في المنع لا في الاثبات، إذ الحكم لا يسبق علته، فيضطر عند بيان المنع بهذه الصفة إلى الرجوع إلى حرف المسألة وهو أن رأي الولي هل يقوم مقام رأيها لانعدام اعتبار رأيها في الحال شرعا فيما يرجع إلى النظر لها كما في المال والبكر والغلام، أم لا يقوم رأيه مقام رأيها لما في ذلك من تفويت الرأي عليها إذا صارت من أهل الرأي بالبلوغ ؟ وبمثل هذا الحد يتبين عوار من شرع في الكلام بناء على حسن الظن قبل أن يتميز له الصواب من الخطأ بطريق الفقه.
وبيان الممانعة في الحكم كثيرة.
منها تعليلهم في تكرار المسح بأنه ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه، لانا لا نسلم هذا الحكم في الاصل، فالمسنون هناك عندنا ليس التكرار، بل الاكمال بالزيادة على قدر المفروض في محله من جنسه كما في أركان الصلاة، فإن إكمال ركن القراءة بالزيادة على القدر المفروض في محله من جنسه وهو تلاوة القرآن.
وكذلك
الركوع والسجود إلا أن في الغسل لما كان الاستيعاب فرضا لا يتحقق فيه الاكمال بهذه الصفة إلا بالتكرار، فكان التكرار مسنونا لغيره وهو تحصيل صفة الاكمال به لا لعينه، وفي الممسوح الاستيعاب ليس بركن فيقع الاستغناء عن التكرار في إقامة سنة الكمال، بل بالزيادة على القدر
المفروض باستيعاب جميع الرأس بالمسح مرة واحدة يحصل الاكمال، وما كان مشروعا لغيره فإنما يشرع باعتباره في موضع تتحقق الحاجة إليه، فأما إذا كان ما شرع لاجله يحصل بدونه لا يفيد اعتباره، ألا ترى أنه لو كرر المسح في ربع الرأس أو أدنى ما يتناوله الاسم لا يحصل به كمال السنة ما لم يستوعب جميع الرأس بالمسح، فبهذا يتبين أن الاكمال هنا بالاستيعاب وأنه هو الاصل، فيجب المصير إليه إلا في موضع يتحقق العجز عنه بأن يكون الاستيعاب ركنا، كما في المغسولات، فحينئذ يصار إلى الاكمال بالتكرار، ولا يلزمنا المسح بالاذنين فإنه مسنون لاكمال المسح بالرأس، وإن لم يكن في محل المفروض حتى لا يتأدى مسح الرأس بمسح الاذنين بحال، لان ذلك المسح لاكمال السنة في المسح بالرأس، ولهذا لا يأخذ لاذنيه ماء جديدا عندنا، ولكن يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس، والمسح فيهما أفضل من الغسل إلا أن كون الاذنين من الرأس لما كان ثابتا بالسنة دون نص الكتاب يثبت اتحاد المحل فيما يرجع إلى إكمال السنة به ولا تثبت المحلية فيما يتأدى به الفرض الثابت بالنص، فقلنا لا ينوب مسح الاذنين عن المسح بالرأس لهذا.
ومن ذلك تعليلهم في صوم رمضان بمطلق النية أنه صوم فرض فلا يتأدى بدون التعيين بالنية كصوم القضاء.
فإنا نقول: ما تعنون لهذا الحكم ؟
التعين بالنية بعد التعين أو قبل التعين أم في الوجهين جميعا ؟ فلا يجدون بدا من أن يقولوا قبل التعين، لان بعد التعين التعيين غير معتبر، وهو ليس بشرط في تأدي صوم القضاء، وإذا قالوا قبل التعين قلنا: هذا ممنوع في الفرع، فإن التعين حاصل هنا بأصل الشرع إذ المشروع في هذا الزمان صوم الفرض خاصة، فغيره ليس بمشروع، فلا نجد بدا حينئذ من الرجوع إلى حرف المسألة وهو أن نية التعيين هل يسقط اشتراطه بكون المشروع متعينا في ذلك الزمان أم لا يسقط اعتباره ؟.
ومن ذلك تعليلهم في بيع المطعوم الذي لا يدخل تحت المعيار بجنسه أنه باع مطعوما بمطعوم من جنسه لا تعرف المساواة بينهما في المعيار فيكون حراما كبيع صبرة حنطة بصبرة حنطة.
فإنا نقول: إيش تعنون بهذا الحكم ؟ أهو حرمة مطلقة أم حرمة إلى غاية التساوي ؟ فإن قالوا: بنا غنية عن بيان هذا.
قلنا: لا كذلك، فالحرمة الثابتة إلى غاية غير الحرمة المطلقة، والحكم الذي يقع التعليل له لا بد أن يكون معلوما.
فإن قال: أعني الحرمة المطلقة، منعنا هذا الحكم في الاصل، لان الحرمة هناك ثابتة إلى غاية وهي المساواة في القدر، وإن عنى الحرمة إلى غاية فقد تعذر إثبات هذه الحرمة بالتعليل في الفرع، لان إثبات الحرمة إلى غاية إنما يتحقق في مال تتصور فيه تلك الغاية، وما لا يدخل تحت المعيار لا يتصور فيه الغاية وهي المساواة في المعيار، فكيف يتحقق إثبات الحرمة فيه إلى غاية ؟ وعند هذا المنع يضطر إلى الرجوع إلى حرف المسألة كما أشرنا إليه.
ومن ذلك تعليلهم في السلم في الحيوان أنه مال يثبت دينا في الذمة مهرا فيثبت دينا في الذمة سلما كالثياب.
فإنا نقول: ما معنى قولكم يثبت دينا
في الذمة ؟ أتريدون به معلوم الوصف أم معلوم المالية والقيمة ؟ فإن قال: أعني معلوم الوصف، منعنا ذلك في الاصل وهو المهر، فقد قامت الدلالة لنا على أنه لا يشترط فيما يثبت في الذمة مهرا أن يكون معلوم الوصف.
فإن قال: نعني معلوم المالية والقيمة، منعنا ذلك في الفرع، فإن الحيوان بعد ذكر الاوصاف يتفاوت في المالية تفاوتا فاحشا.
وإن قالوا: لا حاجة بنا إلى هذا التعيين، قلنا لا كذلك، فاعتبار أحد الدينين بالآخر لا يصح ما لم يثبت أنهما نظيران ولا طريق لثبوت ذلك إلا الايجاد في الطريق الذي يثبت به كل واحد من الدينين في الذمة، وعند ذلك يضطر إلى الرجوع إلى حرف المسألة وهو أن إعلام المسلم فيه على وجه لا يبقى فيه تفاوت فاحش فيما هو المقصود، وهو المالية على وجه يلتحق بذوات الامثال في صفة المالية هل يكون شرطا لجواز عقد السلم أم لا ؟
ومن ذلك تعليلهم في اشتراط التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام أن العقد جمع بدلين يجري فيهما ربا الفضل فيشترط التقابض كالاثمان، فإنا نقول: إيش المراد بقولكم فيشترط فيهما تقابض ؟ أهو التقابض لازالة صفة الدينية أو لاثبات زيادة معنى الصيانة، وأحدهما يخالف الآخر فلا بد من بيان هذا.
فإن قالوا: لمعنى الصيانة، منعنا هذا الحكم في الاثمان، فاشتراط التقابض هناك عندنا لازالة صفة الدينية، فإن النقود لا تتعين في العقود ما لم تقبض، والدين بالدين حرام شرعا.
وإن قالوا: لازالة صفة الدينية، لا يتمكنون من إثبات هذا الحكم في الفرع، فالطعام يتعين في العقد بالتعيين من غير قبض فلا يجدون بدا من الرجوع إلى حرف المسألة، وهو بيان أن اشتراط القبض في الصرف ليس لازالة صفة الدينية بل للصيانة عن معنى
الربا، بمنزلة المساواة في القدر.
ومن ذلك قولهم في من اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه إنه عتق الاب فلا تتأدى به الكفارة كما لو ورثه، لانا نقول: إن عنيتم أنه لا تتأدى الكفارة بالعتق فنحن نقول في الفرع لا تتأدى الكفارة بالعتق، بل الكفارة تتأدى بفعل منسوب إلى المكفر والعتق وصف في المحل ثابت شرعا، وإن عنيتم الاعتاق فهذا غير موجود في الاصل، لانه لا صنع للوارث في الارث حتى يصير به معتقا، وعند هذا لا بد من الرجوع إلى حرف المسألة وهو أن شراء القريب هل هو إعتاق بطريق أنه متمم علة العتق ؟ أم ليس بإعتاق وإنما يحصل العتق به حكما للملك ؟ ومن ذلك قولهم في أن الكفارة لا تتأدى بطعام الاباحة إنه نوع تكفير يتأدى بالتمليك (فلا يتأدى بدون التمليك) كالكسوة، لانا نقول: لا تتأدى بدون التمليك مع امتثال الامر (أم بدون امتثال الامر.
فإن قال: بي غنية عن بيان هذا، قلنا: لا كذلك، لان التكفير مأمور به شرعا فلا يتأدى
المأمور به إلا بما فيه امتثال الامر.
فإن قال: مع امتثال الامر، منعنا هذا الحكم في الاصل وهو إعارة الثوب من المسكين.
وإن قال: بدون امتثال الامر) قلنا: هذا مسلم، ولكنا نمنع انعدام امتثال الامر في الفرع، والمأمور به هو الاطعام، وحقيقته التمكين من الطعام، فيضطر إلى الرجوع إلى حرف المسألة وهو أن حقيقة معنى الاطعام أهو التمكين بالتغدية والتعشية أم التمليك ؟ ومنه قولهم في القطع والضمان إنهما يجتمعان لانه أخذ مال الغير بغير إذن مالكه فيكون موجبا للضمان كالاخذ غصبا.
فإنا نقول: ما معنى
هذا الحكم ؟ أهو أن يكون موجبا للضمان مع وجود ما ينافيه، أم عند عدم ما ينافيه ؟ فإن قال: مع وجود ما ينافيه، منعنا ذلك في الاصل، فإن غصب الباغي مال العادل لا يكون موجبا للضمان، وإن كان آخذا بغير حق وبغير إذن المالك.
وإن قال: عند عدم ما ينافيه، قلنا: بموجبه ولكن لا نسلم انعدام ما ينافي الضمان هنا، فإن قطع اليد بسبب السرقة مناف للضمان عندنا أو مسقط له كالابراء، فلا يجد بدا من الرجوع إلى حرف المسألة وهو أن استيفاء القطع هل يكون منافيا للضمان أم لا ؟ وأما بيان إضافة الحكم إلى الوصف فهو على ما ذكرنا في القول بموجب العلة، فإن إضافة الحكم إلى العلل الطردية ليس بدليل موجب إضافة الحكم إلى ذلك الوصف، بل لكونه موجودا عند وجوده ومعدوما عند عدمه، وقد بينا أن العدم لا يصلح لاضافة الحكم إليه، وكذلك كل تعليل يكون بنفي وصف أو حكم، فإنا نمنع صلاحية ذلك الوصف لاضافة الحكم إليه، نحو تعليلهم في الاخ أنه لا يعتق على أخيه إذا ملكه لانه ليس بينهما بعضية كابن العم، فإنا نمنع في ابن العم أن يكون انتفاء العتق عند دخوله في ملكه لهذا الوصف، إذ العدم لا يجوز أن يكون موجبا شيئا.
وكذلك قولهم في النكاح إنه لا يثبت بشهادة الرجال والنساء لانه ليس بمال كالحدود.
فإنا نمنع إضافة هذا الحكم في الحدود إلى هذا الوصف، لانه كون الحد ليس بمال لا يصلح علة لامتناع ثبوته بشهادة النساء مع الرجال.
وتعليلهم في الاحصار بالمرض أنه لا يفارقه ما حل به بالاحلال، كالذي ضل الطريق الممانعة في الاصل على هذا الوجه.
وتعليلهم في المبتوتة أنها لا تستوجب النفقة ولا يلحقها الطلاق لانها ليست بمنكوحة كالمطلقة
قبل الدخول، فإنا نمنع إضافة هذا الحكم في الاصل إلى هذا الوصف، إذ العدم لا يصلح أن يكون موجبا شيئا.
وعلى هذا فخرج ما شئت من المسائل.
فصل: في بيان فساد الوضع قال رضي الله عنه: اعلم بأن فساد الوضع في العلل بمنزلة فساد الاداء في الشهادة وأنه مقدم على النقض، لان الاطراد إنما يطلب بعد صحة العلة، كما أن الشاهد إنما يشتغل بتعديله بعد صحة أداء الشهادة منه، فأما مع فساد في الاداء لا يصار إلى التعليل لكونه غير مفيد.
ثم تأثير فساد الوضع أكثر من تأثير النقض، لان بعد ظهور فساد الوضع لا وجه سوى الانتقال إلى علة أخرى، فأما النقض فهو جحد مجلس يمكن الاحتراز عنه في مجلس آخر.
وبيانه فيما قال الشافعي في إسلام أحد الزوجين إن الحادث بينهما اختلاف الدين، فالفرقة به لا تتوقف على قضاء القاضي كالفرقة بردة أحد الزوجين.
لانا نقول: هذا الاختلاف إنما حصل بإسلام من أسلم منهما، فأما باعتبار بقاء من بقي على الكفر الحال حال الموافقة فقد كان بينهما الموافقة وهذا على دينه، فعرفنا أن الاختلاف الحادث بإسلام المسلم منهما هو سبب لعصمة الملك وزيادة معنى الصيانة فيه، فالتعليل به لاستحقاق الفرقة يكون فاسدا وضعا في الفرع وإن كان صحيحا في الاصل، من حيث إن الاختلاف هناك حادث بالردة وهي سبب لزوال الملك والعصمة.
وكذلك قولهم في المسح بالرأس إنه ركن في الطهارة فيسن تثليثه كغسل الوجه فاسد وضعا، لانه يرد المسح المبني
على التخفيف إلى الغسل المبني على المبالغة ليثبت في المسح زيادة غلظ فوق ما في الغسل، فإن في الغسل الاكمال بالتثليث في محل الفرض خاصة، وبهذا
التعليل يجعل التثليث في الممسوح مشروعا للاكمال في موضع الفرض وغير موضع الفرض، فإن الفرض يتأدى بالربع وهو يجعل التثليث مسنونا بالاستيعاب.
ومن ذلك قولهم في الضرورة إذا حج بنية النفل يقع عن الفرض لان فرض هذه العبادة يتأدى بمطلق النية، فيتأدى بنية النفل أيضا كالزكاة، فإن التصدق بالنصاب على الفقير بمطلق النية لما كان يتأدى به الزكاة فنية النفل كان كذلك.
ولكنا نقول: هذا فاسد وضعا، لانه بهذا الطريق يرد المفسر إلى المجمل، ويحمل المقيد على المطلق، وإنما المجمل يرد إلى المفسر ليصير به معلوم المراد، والمطلق يحمل على المقيد عنده في حادثتين أو في حكمين، وعندنا في حادثة واحدة في حكم واحد، حتى رددنا مطلق القراءة في صوم ثلاثة أيام في اليمين إلى المقيد بالتتابع في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وأحد لا يقول المقيد يحمل على المطلق، وهو نظير مطلق النقد ينصرف إلى نقد البلد المعروف لدلالة العرف، فأما المقيد بنقد آخر فإنه لا يحمل على المطلق لينصرف إلى نقد البلد.
ومن ذلك قولهم في علة الربا إن صفة الطعم معنى يتعلق به البقاء، يعنون أن بقاء النفس يكون بالطعم فيكون ذلك علة موجبة لزيادة شرطين في العقد على المطعوم عند مقابلة الجنسية.
ونحن نقول: هذا فاسد وضعا، لان البيع في الاصل ما شرع إلا للحاجة ولهذا اختص بالمال الذي بذله لحوائج الناس، وصفة الطعم تكون عبارة عن أعظم أسباب الحاجة إلى ذلك المال، لان ما يتعلق به البقاء يحتاج إليه كل واحد، وذلك إنما يصلح علة لصحة العقد وتوسعة الامر فيه لا للحرمة، لان تأثير الحاجة في
الاباحة بمنزلة إباحة الميتة عند الضرورة، ولهذا حل لكل واحد من الغانمين تناول مقدار الحاجة من الطعام والعلف الذي يكون في الغنيمة في دار الحرب قبل القسمة بخلاف سائر الاموال، فكانت العلة فاسدة وضعا مع أنه لا تأثير لها في إثبات المماثلة بين العوضين الذي هو شرط جواز العقد بالنص.
ومن ذلك قولهم في طول الحرة إن الحر لا يجوز له أن يرق ماءه مع غنيته عنه، كما لو كان تحته حرة، فإن تأثير الحرية في أصل الشرع في استحقاق زيادة النعمة والكرامة وفي إثبات صفة الكمال في الملك، ولهذا حل للحر أربع نسوة بالنكاح ولم يحل للعبد إلا اثنتان، فالتعليل لاثبات الحجر عن العقد بصفة الحرية فيما لا يثبت الحجر عنه بسبب الرق يكون فاسدا في الوضع مخالفا لاصول الشرع.
ومن ذلك قولهم فيمن جن في وقت صلاة كامل أو في يوم واحد في الصوم إنه لا يلزمه القضاء، لان الخطاب عنه ساقط أصلا ووجوب القضاء يبتنى على وجوب الاداء، بمنزلة ما لو جن أكثر من يوم وليلة في الصلاة، أو استوعب الجنون الشهر كله في الصوم.
ونحن نقول: هذا فاسد وضعا، لان الحادث بالجنون عجز عن فهم الخطاب والائتمار بالامر ولا أثر للجنون في إخراجه من أن يكون أهلا للعبادة، لان ذلك يبتنى على كونه أهلا لثوابها، والاهلية لثواب العبادة بكونه مؤمنا والجنون لا يبطل إيمانه، ولهذا يرث المجنون قريبه المسلم، ولا يفرق بين المجنونة وزوجها المسلم.
والدليل عليه أنه لا يبطل إحرامه بسبب الجنون، فدل أنه لا يبطل به إيمانه فكذلك لا يبطل صومه، حتى لو جن بعد الشروع في الصوم بقي صائما، ولا وجه لانكار هذا، فإن بعد صحة الشروع في الصوم لا يشترط قيام
الاهلية للبقاء فيها سوى الكف عن اقتضاء الشهوات، والجنون لا ينفي تحقق هذا الفعل، وإذا بقي صائما حتى تأدى منه عرفنا أنه تأدى فرضا كما شرع
فيه، ولا يتحقق ذلك إلا مع تقرر سبب الوجوب في حقه.
والدليل عليه بقاء حجة الاسلام فرضا له بعد الجنون، وبقاء ما أدى من الصلاة في حالة الافاقة فرضا في حقه، فبهذا التحقيق يتبين أن سبب الوجوب متحقق مع الجنون، والخطاب بالاداء ساقط عنه لعجزه عن فهم الخطاب، وذلك لا ينفي صحة الاداء فرضا، بمنزلة من لم يبلغه الخطاب، فإنه تتأدى منه العبادة بصفة الفرضية كمن أسلم في دار الحرب ولم تبلغه فرضية الخطاب لا يكون مخاطبا بها ومع ذلك إذا أداها كانت فرضا له.
وكذلك النائم والمغمى عليه، فإن الخطاب بالاداء ساقط عنهما قبل الانتباه والافاقة ثم كان السبب متقررا في حقهما، فكان التعليل بسقوط فعل الاداء عنه لعجزه عن فهم الخطاب على نفي سبب الوجوب في حقه أصلا، فيكون فاسدا وضعا مخالفا للنص والاجماع، ولان الخطاب بالاداء يشترط لثبوت التمكن من الائتمار وذلك لا يكون بدون العقل والتمييز، فسقوطه لانعدام شرطه لا يجوز أن يكون دليلا على نفي تقرر السبب، وثبوت الوجوب الذي هو حكم السبب على وجه لا صنع للعبد فيه بل هو أمر شرعي يختص بمحل صالح له وهو الذمة، فإذا ثبت تقرر السبب ثبت صحة الاداء، ووجوب القضاء عند عدم الاداء بشرط أن لا يلحقه الحرج في القضاء، فإن الحرج عذر مسقط بالنص، قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) فعند تطاول الجنون حقيقة أو حكما بتكرار الفوائت من الصلوات وباستيعاب الجنون الشهر كله أسقطنا القضاء
لدفع الحرج وهو عذر مسقط.
ومعنى الحرج فيه أنه تتضاعف عليه العبادة المشروعة في وقتها، ولا يشتبه معنى الحرج في الاداء عند تضاعف الواجب، ولهذا أسقطنا بعذر الحيض قضاء الصلوات لانها تبتلى بالحيض في كل شهر عادة، والصلاة يلزمها في اليوم والليلة خمس مرات، فلو أوجبنا القضاء تضاعف الواجب في زمان الطهر، ولا يسقط بالحيض قضاء الصوم، لان فرضية
الصوم في السنة في شهر واحد وأكثر الحيض في ذلك الشهر عشرة، فإيجاب قضاء عشرة أيام في أحد عشر شهرا لا يكون فيه كثير حرج، ولا يؤدي إلى تضاعف الواجب في وقته.
وكذلك إذا لزمها صوم شهرين في كفارة القتل فأفطرت بعذر الحيض لم يلزمها الاستقبال، بخلاف ما إذا لزمها صوم عشرة أيام متتابعة بالنذر فأفطرت بعذر الحيض في خلالها يلزمها الاستقبال، لانها قلما تجد شهرين خاليين عن الحيض عادة، ففي التحرز عن الفطر بعذر الحيض في شهرين معنى الحرج ولا يتحقق ذلك في عشرة أيام، ولهذا أسقطنا قضاء العبادات عن الصبي بعد البلوغ، لان الصبي لا يكون إلا متطاولا عادة فيتحقق معنى الحرج في إيجاب القضاء.
ولم يسقط القضاء عن النائم لانه لا يكون متطاولا عادة فلا يلحقه الحرج في إيجاب القضاء بعد الانتباه، وألحقنا الاغماء بالجنون في حكم الصلاة، لان ذلك يوجد عادة في مقدار ما يتكرر به الفائت من الصلاة، وألحقناه بالنوم في حكم الصوم لانه لا يتطاول عادة بقدر ما يثبت به حكم تطاول الجنون في حكم الصوم وهو أن يستوعب الشهر كله.
ومن ذلك قولهم في النقود إنها تتعين في عقود المعاوضات لانها تتعين في التبرعات كالهبة والصدقة فتتعين في المعاوضات بمنزلة الحنطة وسائر السلع، لانا
نقول: هذا التعليل فاسد وضعا، فإن التبرعات مشروعة في الاصل للايثار بالعين لا لايجاب شئ منها في الذمة، والمعاوضات لايجاب البدل بها في الذمة ابتداء، ألا ترى أن البيع في العرف الظاهر إنما يكون بثمن يجب في الذمة ابتداء، والنكاح يكون بصداق يجب في الذمة ابتداء، فكان اعتبار ما هو مشروع للالزام في الذمة ابتداء إنما هو مشروع لنقل الملك واليد في العين من شخص إلى شخص في حكم التعيين فاسدا وضعا، ألا ترى أن البيع لما كان لنقل الملك واليد في عين المعقود عليه لم يجز أن يكون موجبا المبيع في الذمة ابتداء لا رخصة بسبب الحاجة إليه في السلم، وذلك حكم ثابت بخلاف القياس،
ففيما يكون البيع موجبا له في الذمة ابتداء وهو الثمن لا يجوز أن يجعل موجبه نقل الملك واليد فيه من شخص إلى شخص بالتعيين، وقد عرفنا أنه لا يستحق النقد بالعقد الذي هو معاوضة إلا ثمنا، ومع التعيين لا يمكن إثبات موجبه، فظهر أن هذا التعيين لم يصادف محله وأنه بمنزلة هبة المال دينا في ذمته من إنسان فإنه لا يكون صحيحا، لان موجب الهبة نقل الملك واليد في العين، فلا يجوز أن يجعل موجبه الايجاب في الذمة ابتداء بالشك، وما كان تعيين النقد في عقد المعاوضة إلا نظير الايجاب في الذمة ابتداء بعقد الهبة، فكما أن ذلك ينافي صحة العقد لان موجبه نقل الملك في العين واليد، فبدون موجبه لا يكون صحيحا، فهنا لو تعين بطل العقد، لانه ينعدم ما هو موجب هذا العقد في الثمن وهو الالزام في الذمة ابتداء، وفي الحنطة كذلك، فإنه متى كان ثمنا كان واجبا في الذمة ابتداء، فأما بعد التعيين يصير مبيعا فيكون موجب العقد فيه تحويل ملك العين واليد من شخص إلى شخص، والسلع لا تكون إلا مبيعة، ولهذا لا يجوز ترك التعيين فيها في غير موضع الرخصة
وهو السلم الذي هو ثابت بخلاف القياس، لانه لو صح ذلك كان ثابتا بالعقد في الذمة ابتداء وهو خلاف موجب العقد فيها.
ومن ذلك قولهم في المشتري إذا أفلس في الثمن قبل النقد إنه يثبت للبائع حق نقض البيع واسترداد سلعته، لان الثمن أحد العوضين في البيع، فالعجز عن تسليمه بحكم العقد يثبت للمتملك حق فسخ العقد دفعا للضرر عن نفسه، كالعوض الآخر وهو المبيع إذا كان عينا فعجز البائع عن تسليمه بالاباق أو كان دينا كالسلم، فعجز البائع عن تسليمه بانقطاعه عن أيدي الناس.
لانا نقول: هذا التعليل فاسد وضعا، فإن موجب البيع في المبيع استحقاق ملك العين واليد، ولهذا لا نجوز بيع العين قبل وجود الملك واليد للبائع في المبيع، لانه لا يتحقق منه اكتساب سبب استحقاق ذلك لغيره إذا لم يكن مستحقا له، وكذلك في المبيع الدين يشترط قدرته على التسليم باكتسابه حكما بكونه موجودا في العالم وباشتراط الاجل الذي هو مؤثر
في قدرته على التسليم باكتسابه في المدة أو إدراك غلاته، فإنه موجب بالعقد في الثمن التزامه في الذمة ابتداء، والشرط فيه ذمة صالحة للالتزام فيها، ولهذا لا يشترط قيام ملك المشتري في الثمن وقدرته على تسليمه عند العقد حقيقة وحكما.
فتبين بهذا أن بسبب العجز عن تسليم المعقود عليه يتمكن خلل فيما هو موجب العقد فيه (وهو) مستحق به، وبسبب العجز عن تسليم الثمن لا يتمكن الخلل فيما هو موجب العقد فيه وهو التزام (الثمن) في الذمة، وأي فساد أبين من فساد قول من يقول إذا ثبت حق الفسخ عند تمكن الخلل في موجب العقد ينبغي أن يثبت حق الفسخ بدون تمكن الخلل في موجب العقد.
والدليل على ما قلنا جواز إسقاط حق قبض الثمن بالابراء أصلا وعدم
جواز ذلك في المبيع المعين قبل القبض، حتى إنه إذا وهبه من البائع وقبله كان فسخا للبيع بينهما.
ولا يدخل على ما ذكرنا الكتابة، فإن عجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة بعد محل الاجل تمكن المولى من الفسخ، والبدل هناك معقود به يثبت في الذمة ابتداء ولا يتمكن الخلل فيما هو موجب العقد فيه بسبب العجز عن تسليمه، لان موجب العقد لزوم بدل الكتابة على أن يصير ملكا للمولى بعد حل الاجل بالاداء، فإن المولى لا يستوجب على عبده دينا، ولهذا لا تجب الزكاة في بدل الكتابة ولا تصح الكفالة به.
فعرفنا أن الملك هناك لا يسبق الاداء، فإذا عجز عن الاداء فقد تمكن الخلل في الملك الذي هو موجب العقد فيه، فأما هنا موجب العقد ملك الثمن دينا في الذمة ابتداء وذلك قد تم بنفس العقد، وبسبب الافلاس لا يتمكن الخلل فيما هو موجب العقد، ولهذا لو مات مفلسا لا يتمكن البائع من فسخ العقد أيضا، وإن لم تبق صلاحية المحل وهو الذمة بعد موته مفلسا، لان بنفس العقد قد تم موجب العقد فيه، فما كان فواته بعد ذلك إلا بمنزلة هلاك المبيع بعد القبض، وذلك لا يوجب انفساخ العقد ولا يثبت للمشتري به حق الفسخ فهذا مثله.
وهذه المسائل فقههم فيها بطريق إحالة العلة أظهر وأنور للقلوب، وقد بينا فساد الوضع
في عللهم فيها ليتبين لك أن أكثر ما يعللون به في المسائل بهذا الطريق فاسد إذا تأملت فيه، وأن أعدل الطرق في تصحيح العلة ما كان عليه السلف من اعتبار التأثير.
فصل: المناقضة قد بينا تفسير النقض وحده فيما مضى، وهذا الفصل لبيان الدفع بالمناقضة يلجئ أصحاب الطرد إلى الاحتجاج بالتأثير.
وبيانه فيما علل به الشافعي رحمه الله في اشتراط النية في الوضوء أن التيمم والوضوء طهارتان كيف يفترقان، لان عند إطلاق إنكار التفرقة بينهما ينتقض بكل وجه يفترقان فيه من اشتراط أصل الفعل في التيمم دون الوضوء، ومن اشتراط الاعضاء الاربعة في الوضوء دون التيمم، ومن صفة كل واحد منهما، وغير ذلك مما يفترقان فيه.
فإن قال: عنيت إثبات التسوية بينهما في اشتراط النية خاصة بهذا الوصف، قلنا: هو باطل بغسل النجاسة عن الثوب أو البدن فإنه طهارة ثم لا يشترط فيه النية، فيضطر عند ذلك إلى الرجوع إلى التأثير، وهو أن كل واحد منهما طهارة حكمية غير معقولة المعنى بل ثابتة شرعا بطريق التعبد، إذ ليس على الاعضاء شئ يزول بهذه الطهارة والعبادة لا تتأدى بدون النية، بخلاف غسل النجاسة فإنه معقول بما فيه من إزالة عين النجاسة عن الثوب أو البدن.
ونحن نقول: الماء بطبعه مطهر كما أنه بطبعه مزيل فإنه خلق لذلك، قال الله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) والطهور الطاهر بنفسه المطهر لغيره يعمل في التطهير من غير النية، كالنار لما كانت محرقة بطبعها تعمل في الاحراق بغير النية، ثم الحدث لا يختص بالاعضاء بل يثبت حكمه في جميع البدن كالجنابة والحيض والنفاس، لانه لو اختص بموضع كان أولى المواضع به مخرج الحدث ولا يثبت لزوم التطهير في ذلك الموضع، فعرفنا أنه ثابت في جميع البدن إلا أن الشرع أقام غسل الاعضاء التي هي ظاهرة، وهي بمنزلة الامهات في تطهيرها بالماء، مقام جميع البدن تيسيرا على العباد، لان إقامة الغسل فيها تيسير على وجه
لا يتيسر في سائر أجزاء البدن، وسبب الحدث تعم به البلوى ويعتاد تكراره في كل وقت، وبقي حكم تطهير جميع البدن بالغسل في الجنابة والحيض والنفاس
على أصل القياس، فظهر أن ما لا يعقل فيه المعنى بل هو ثابت شرعا إقامة المحال المخصوصة مقام جميع البدن لا فعل هو استعمال الماء في حصول الطهارة به، وكلامنا في اشتراط النية في الفعل الذي يحصل به الطهارة دون المحل، وفي هذه الطهارة من الحدث والجنابة بمنزلة غسل النجاسة.
وكذلك المسح بالرأس فإنه قائم مقام فعل الغسل الذي هو تطهير في ذلك العضو بمعنى التيسير، بخلاف التيمم فإنه في الاصل تلويث وتغبير وهو ضد التطهير، ولهذا لا يرتفع به الحدث، فعرفنا أنه جعل طهارة لضرورة الحاجة إلى أداء الصلاة فإنما يكون طهارة بشرط إرادة الصلاة، وهذا الشرط لا يتحقق إلا بالنية، وما يقول إن في الوضوء والاغتسال معنى العبادة فشرط العبادة النية فهو مسلم عندنا، ومتى لم توجد النية لا يكون وضوءه عبادة، ولكن الطهارة التي هي شرط صحة أداء الصلاة ما يكون مزيلا للحدث لا ما يكون عبادة، واستعمال الماء في محل الطهارة بدون النية مزيل للحدث، فبهذا التقرير تبين أن الوضوء نوعان: نوع هو عبادة وهو لا يحصل بدون النية، ونوع هو مزيل للحدث وهو حاصل بغير النية بمنزلة الغسل الذي هو مزيل للنجاسة وهو مثبت شرط جواز الصلاة.
ومن ذلك قولهم: الطلاق ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال كالحدود.
فإن مطلق هذه العبارة تنتقض بالبكارة والرضاع فلا بد من الرجوع إلى التأثير وهو أن شهادة النساء مع الرجال ليس بحجة أصلية، ولكنها حجة ضرورة يجوز العمل بها شرعا فيما تكثر به البلوى والمعاملة فيه بين الناس في كل وقت، وذلك الاموال وما يتبع الاموال، ففيما لا يكثر فيه البلوى لا تجعل فيه شهادة النساء
حجة، والنكاح والطلاق والوكالة وما أشبه ذلك لا يوجد فيها من عموم البلوى
مثل ما يكون في الاموال.
ونحن نقول: إنها حجة أصلية بمنزلة شهادة الرجال، ولكن فيها ضرب شبهة باعتبار نقصان عقل النساء لتوهم الضلال والنسيان لكثرة غفلتهن، ولهذا ضمت إحدى المرأتين إلى الاخرى ليكونا كرجل واحد في الشهادة، فإنما لا يثبت بهذه الشهادة ما يندرئ بالشبهات كالحدود، فأما النكاح يثبت مع الشبهات، ألا ترى أنه أسرع ثبوتا من المال حتى يصح من الهازل والمكره والمخطئ عندنا، وكذلك الطلاق والوكالة فإنها تثبت مع الجهالة فتحتمل التعليق بالشرط، فكانت أقرب إلى الثبوت مع الشبهة من الاموال بخلاف الحدود.
ومن ذلك قولهم: الغصب عدوان محض فلا يكون سببا للملك في العين كالقتل، لان هذا ينتقض باستيلاد الاب جارية ابنه واستيلاد أحد الشريكين الجارية المشتركة، فإنه عدوان من حيث إنه حرام ثم كان سببا للملك، فيضطر المعلل عند إيراد هذا النقض إلى الرجوع إلى التأثير، وهو أن الفعل إنما يتمخض عدوانا إذا خلا عن نوع شبهة، واستيلاد أحد الشريكين لم يخل عن ذلك، فإنه باعتبار جانب ملكه يتمكن شبهة في هذا الفعل، وكذلك ما للاب من الحق في مال ولده يمكن شبهة.
فنقول عند ذلك: الغصب الذي هو عدوان محض لا يكون سببا لملك العين عندنا ولكن ثبوت الملك في بدل العين وهو حكم مشروع غير موصوف بأنه عدوان هو الذي ثبت به الملك في العين شرطا له على ما قررنا.
ومن ذلك قوله في المنافع: إن المتلف مال فيكون مضمونا على المتلف ضمانا يستوفى كالعين، لان ظاهر هذا ينتقض بما إذا كان المتلف معسرا لا يجد شيئا.
فإن قال هناك الضمان واجب عندي ولكن يتأخر الاستيفاء لعجز من عليه عن المثل الذي يؤدي به الضمان.
قلنا: هكذا نقول في الفرع، فإن
عندنا يتأخر استيفاء الضمان إلى الآخرة للعجز عن المثل الذي يوفي به هذا
الضمان، فإن ضمان العدوان يتقدر بالمثل بالنص وليس للمنفعة مثل في صفة المالية يمكن استيفاؤها في الدنيا، وعند ذلك يتبين فقه المسألة أن المانع من إلزام الضمان عندنا انعدام المماثلة لظهور التفاوت بين المنافع والاعيان في صفة المالية، وقد تقدم بيان ذلك، فيقرر بما ذكرنا أن الاعتماد على الاطراد من غير طلب التأثير ضعيف في باب الاحتجاج، وأنه بمنزلة الاحتجاج بلا دليل على ما أوضحنا فيه السبيل.
فصل: في بيان الانتقال قال رضي الله عنه: الانتقال على أربعة أوجه: انتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الاولى بها، وانتقال من حكم إلى حكم لاثباته بالعلة الاولى، وانتقال من حكم إلى حكم (آخر) لاثباته بعلة أخرى.
وهذه الاوجه الثلاثة مستقيمة على طريق النظر لا تعد من الانقطاع.
أما الاول فلان المعلل إنما التزم إثبات الحكم بما ذكره من العلة ويمكنه من ذلك بإثبات العلة، فما دام سعيه فيما يرجع إلى إثبات تلك العلة يكون ذلك وفاء منه بما التزم لا أن يكون إعراضا عن ذلك واشتغالا بشئ آخر.
وبيان هذا فيما إذا عللنا في نفي الضمان عن الصبي المستهلك للوديعة بأنه استهلاك عن تسليط صحيح ثم نشتغل بإثبات هذه العلة، فإنه يكون هذا انتقالا من علة إلى أخرى لاثبات العلة الاولى بها، ولا يشك أحد في أن ذلك مستقيم على طريق النظر، وعلى هذا إذا اشتغل بإثبات الاصل الذي يتفرع منه موضع الخلاف حتى يرتفع الخلاف بإثبات الاصل فإن ذلك حسن صحيح، نحو ما إذا وقع الاختلاف في الجهر بالتسمية، فإذا قال المعلل: هذا يبتنى على أصل وهو أن التسمية ليست
بآية من الفاتحة ثم يشتغل بإثبات ذلك الاصل حتى يثبت الفرع بثبوت الاصل يكون مستقيما.
وكذلك إذا علل بقياس فقال خصمه: القياس عندي ليس بحجة، فاشتغل بإثبات كونه حجة بقول صحابي، فيقول خصمه: قول الواحد
من الصحابة عندي ليس بحجة، فاشتغل بإثبات كونه حجة بخبر الواحد، فيقول خصمه: خبر الواحد عندي ليس بحجة، فيحتج بكتاب على أن خبر الواحد حجة، فإنه يكون طريقا مستقيما، ويكون هذا كله سعيا في إثبات ما رام إثباته في الابتداء.
وأما الثاني فلان الانتقال من حكم إلى حكم إنما يكون عند موافقة الخصم في الحكم الاول، وما كان مقصود المعلل إلا طلب الموافقة في ذلك الحكم، فإذا وافقه خصمه فيه فقد تم مقصوده، ثم الانتقال بعده إلى حكم آخر ليثبته بالعلة الاولى يدل على قوة تلك العلة في إجرائها في المعلولات وعلى حذاقة المعلل في إثبات الحكم بالعلة، وذلك نحو ما إذا عللنا في تحرير المكاتب عن كفارة اليمين، لان الكتابة عقد معاوضة يحتمل الفسخ فلا تخرج الرقبة من أن تكون محلا للصرف إلى الكفارة كالبيع، فإذا قال الخصم: عندي عقد الكتابة لا يخرج الرقبة من الصلاحية لذلك، ولكن نقصان الرق هو الذي يخرج الرقبة من ذلك فنقول: بهذه العلة يجب أن لا يتمكن نقصان في الرق لان ما يمكن نقصانا في الرق لا يكون فيه احتمال الفسخ، فهذا إثبات الحكم الثاني بالعلة الاولى أيضا وهو نهاية في الحذاقة.
وكذلك إن تعذر إثبات الحكم الثاني بالعلة الاولى فأراد إثباته بالعلة بعلة أخرى، لانه ما ضمن بتعليله إثبات جميع الاحكام بالعلة الاولى وإنما ضمن إثبات الحكم الذي زعم أن خصمه ينازعه فيه، فإذا أظهر الخصم الموافقة فيه واحتاج إلى إثبات حكم آخر يكون له أن يثبت ذلك بعلة
أخرى ولا يكون هذا انقطاعا منه.
فأما الوجه الرابع وهو الانتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الحكم الاول، فمن أهل النظر من صحح ذلك أيضا ولم يجعله انقطاعا، استدلالا بقصة الخليل عليه السلام حين حاج اللعين بقوله تعالى: (ربي الذي يحيي ويميت) فلما قال اللعين: (أنا أحيي وأميت) حاجه بقوله تعالى: (فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) وكان ذلك (منه)
انتقالا من حجة إلى حجة لاثبات شئ واحد، وقد ذكر الله تعالى ذلك عنه على وجه المدح له به، فعرفنا أنه مستقيم.
وكذلك المدعي إذا أقام شاهدين فعورض بجرح فيهما كان له أن يقيم شاهدين آخرين لاثبات حقه.
والمذهب الصحيح عند عامة الفقهاء أن هذا النوع من الانقطاع، لانه رام إثبات الحكم بالعلة الاولى، فانتقاله عنها إلى علة أخرى قبل أن يثبت الحكم بالعلة الاولى لا يكون إلا لعجز عن إثباته بالعلة الاولى، وهذا انقطاع على ما نبينه في فصله.
ثم مجالس النظر للابانة، فلو جوزنا الانتقال فيها من علة إلى علة أدى ذلك إلى أن يتطاول المجلس ولا يحصل ما هو المقصود وهو الابانة، وكان هذا نظير نقض يتوجه على العلة، فإنه لا يشتغل بالاحتراز عنه، ولكن إذا تعذر دفعه بما ذكره المعلل في الابتداء يظهر به انقطاعه في ذلك المجلس فهذا مثله.
فأما قصة الخليل عليه الصلاة والسلام فهو ما انتقل قبل ظهور الحجة الاولى له، ولكن الاولى كانت حجة ظاهرة لم يطعن خصمه فيها إنما ادعى دعوى مبتدأة بقوله: (أنا أحيي وأميت) وكل ما صنعه معلوم الفساد عند المتأملين إلا أنه كان في القوم من يتبع الظاهر ولا يتأمل في حقيقة المعنى فخاف الخليل عليه الصلاة والسلام الاشتباه
على أمثالهم فضم إلى الحجة الاولى حجة ظاهرة لا يكاد يقع فيها الاشتباه فبهت الذي كفر.
وهذا مستحسن في طريق النظر لا يشك فيه، فإن المعلل إذا أثبت علته يقول: والذي يوضح ما ذكرت.
فيأتي بكلام آخر هو أوضح من الاول في إثبات ما رام إثباته، وهذا لان حجج الشرع أنوار فضم حجة إلى حجة كضم سراج إلى سراج، وذلك لا يكون دليلا على ضعف أحدهما أو بطلان أثره فكذلك ضم حجة إلى حجة، وإنما جعلنا هذا انقطاعا في موضع يكون الانتقال للعجز عن إثبات الحكم بالعلة الاولى.
ثم كل هذه التصرفات للمجيب لا للسائل، فإن المجيب بان والسائل هادم مانع، والحاجة إلى هذه الانتقالات للباني المثبت لا للمانع الدافع.
فصل: بيان الانقطاع ووجوه الانقطاع أربعة: أحدها - وهو أظهرها - السكوت على ما أخبر الله به عن اللعين عند إظهار الخليل صلى الله عليه وسلم حجته بقوله: (فبهت الذي كفر) .
والثاني: جحد ما يعلم ضرورة بطريق المشاهدة، لان سعي المعلل ليجعل الغائب كالشاهد، والعلم بالمشاهدات يثبت ضرورة، فإذا اشتغل الخصم بجحد مثله علم أنه ما حمله على ذلك إلا عجزه عن دفع علة المعلل، فكان انقطاعا.
والثالث: المنع بعد التسليم، فإنه يعلم أنه لا شئ يحمله على المنع بعد التسليم إلا عجزه عن الدفع لما استدل به خصمه.
ولا يقال يحتمل أن يكون تسليمه عن سهو أو غفلة، لان عند ذلك يبين وجه الدفع بطريق التسليم ثم يبنى عليه استدراك ما سها فيه، فأما أن يرجع عن التسليم إلى المنع من غير بيان الدفع بطريق التسليم فذلك لا يكون إلا للعجز.
والرابع: عجز المعلل عن تصحيح العلة التي قصد إثبات الحكم بها حتى انتقل منها إلى علة أخرى لاثبات الحكم، فإن ذلك انقطاع، لان حكم الانقطاع مقتضب من لفظه، وهو قصور المرء عن بلوغ مغزاه، وعجزه عن إظهار مراده ومبتغاه.
وهذا العجز نظير العجز ابتداء عن إقامة الحجة على الحكم الذي ادعاه، والله أعلم.
باب: أقسام الاحكام وأسبابها وعللها وشروطها وعلاماتها اعلم أن جملة ما ثبت بالحجج الشرعية الموجبة للعلم بما تقدم ذكرها قسمان: الاحكام المشروعة وما يتعلق بها المشروعات.
فنبدأ ببيان قسم الاحكام فنقول: هذه الاحكام أربعة: حقوق الله خالصا، وحقوق العباد خالصا أيضا، وما يشتمل على الحقين وحق الله فيه أغلب، وما يشتمل عليهما وحق العباد فيه أغلب.
فأما حقوق الله خالصة فهي أنواع ثمانية: عبادات محضة، وعقوبات محضة، وعقوبة قاصرة، ودائرة بين العبادة والعقوبة، وعبادة فيها معنى المئونة، ومئونة فيها معنى العبادة، ومئونة فيها معنى العقوبة، وما يكون قائما بنفسه وهي على ثلاثة أوجه: ما يكون منه أصلا، وما يكون زائدا على الاصل، وما يكون ملحقا به.
فأما العبادات المحضة فرأسها الايمان بالله تعالى، والاصل فيه التصديق بالقلب، فإنه لا يسقط بعذر ما من إكراه أو غيره، وتبديله بغيره يوجب الكفر على كل حال، والاقرار باللسان ركن فيه مع التصديق بالقلب في أحكام الدنيا والآخرة جميعا، وقد يصير الاقرار أصلا في أحكام الدنيا بمنزلة
التصديق، حتى إذا أكره على الاسلام فأسلم باللسان فهو مسلم في أحكام الدنيا لوجود ركن الاقرار، وقيام السيف على رأسه دليل على أنه غير مصدق بالقلب، ولهذا لا يحكم بالردة إذا أكره المرء عليها، لان التكلم باللسان هناك دليل محض على ما في الضمير من غير أن يجعل أصلا بنفسه، والاقرار باللسان وإن كان دليلا على التصديق فعند الاكراه يجعل أصلا بنفسه يثبت به الايمان في أحكام الدنيا بمنزلة التصديق، ويستوي إن أكره الحربي على ذلك أو الذمي عندنا لهذا المعنى.
وعند الشافعي متى كان الاكراه بحق بأن كان المكره حربيا لا أمان له كذلك الجواب، ومتى كان بغير حق بأن أكره الذمي عليه فإنه لا يصير مسلما به.
ثم الصلاة بعد الايمان من أقوى الاركان، فإنها عماد الدين ما خلت عنها شريعة المرسلين.
وهي تشمل الخدمة بظاهر البدن وباطنه، ولكنها صارت قربة بواسطة البيت الذي عظمه الله وأمرنا بتعظيمه لاضافته إلى نفسه فقال: (أن طهرا بيتي للطائفين) الآية، حتى لا تتأدى هذه القربة إلا باستقبال القبلة في حالة الامكان، وفي ذلك من معنى التعظيم ما أشار الله تعالى إليه في قوله: (فأينما تولوا فثم وجه الله) ليعلم به أن المطلوب
وجه الله، ووجه الله لا جهة له، فجعل الشرع استقبال جهة الكعبة قائما مقام ما هو المطلوب لاداء هذه القربة.
وأصل الايمان فيه تقرب إلى الله تعالى بلا واسطة، وفي الصلاة تقرب بواسطة البيت فكانت من شرائع الايمان لا من نفس الايمان.
ثم الزكاة التي تؤدي بأحد نوعي النعمة وهو المال، فالنعم الدنيوية نعمتان: نعمة البدن، ونعمة المال، والعبادات مشروعة لاظهار شكر النعمة بها في الدنيا ونيل الثواب في الآخرة، فكما أن شكر نعمة البدن
بعبادة تؤدي بجميع البدن وهي الصلاة، فشكر نعمة المال بعبادة مؤداة بجنس تلك النعمة، وإنما صار الاداء قربة بواسطة المصروف إليه وهو المحتاج، على معنى أن المؤدي يجعل ذلك المال خالصا لله تعالى في ضمن صرفه إلى المحتاج ليكون كفاية له من الله تعالى، لهذا كان دون الصلاة بدرجة، فإنها قربة بواسطة البيت الذي ليس من أهل الاستحقاق بذاته، وهذا قربة بواسطة الفقير الذي هو من أهل أن يكون مستحقا بنفسه لحاجته.
ثم الصوم الذي هو من جنس المشروع شكرا لنعمة البدن، ولكنه دون الصلاة من حيث إنه لا يشتمل على أعمال متفرقة على أعضاء البدن، بل يتأدى بركن واحد وهو الكف عن اقتضاء الشهوتين: شهوة البطن وشهوة الفرج، فإنما صارت قربة بواسطة النفس المحتاجة إلى نيل اللذات والشهوات، فهي أمارة بالسوء كما وصفها الله تعالى به، ففي قهرها بالكف عن اقتضاء شهواتها لابتغاء مرضاة الله تعالى معنى القربة، وبالتأمل في هذه الوسيلة يتبين أنه دون ما سبق.
ثم الحج الذي هو زيارة البيت المعظم، وعبادة بطريق الهجرة يشتمل على أركان تختص بأوقات وأمكنة، وفيها معنى القربة باعتبار معنى التعظيم لتلك الاوقات والامكنة.
فأما العمرة فإنها سنة قوية باعتبار أن أركانها من جنس أركان الحج، وما بينا من الوسيلة لا يوجب عددا من القربة ولهذا لا تتكرر فرضية
الحج في العمر، فعرفنا أن العمرة زيارة، وهي سنة قوية فعلها رسول الله عليه السلام وأمر بها.
والجهاد قربة باعتبار إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين، ولما فيه من توهين
المشركين ودفع شرهم عن المسلمين، ولهذا سماه رسول الله عليه السلام سنام الدين.
وكان أصله فرضا لان إعزاز الدين فرض ولكنه فرض كفاية، لان المقصود وهو كسر شوكة المشركين ودفع شرهم وفتنتهم يحصل ببعض المسلمين فإذا قام به البعض سقط عن الباقين.
والاعتكاف قربة زائدة لما فيها من تعظيم المكان المعظم بالمقام فيه وهو المسجد، ولما في شرطها من منع النفس عن اقتضاء الشهوات، يعني الصوم.
والمقصود بها تكثير الصلاة إما حقيقة أو حكما بانتظار الصلاة في مكانها على صفة الاستعداد لها بالطهارة.
وأما صدقة الفطر فهي عبادة فيها معنى المئونة، ولهذا لا تتأدى بدون نية العبادة بحال، ولا تجب إلا على المالك لما يؤدي به حقيقة بمنزلة الزكاة، ولكن لا يشترط لوجوبها صفة كمال الملك والولاية حتى تجب على الصبي في ماله بخلاف الزكاة، وتجب على الغير بسبب الغير، فعرفنا أن فيها معنى المئونة كالنفقة.
وأما العشر فهو مئونة فيه معنى العبادة.
والخراج مئونة فيه معنى العقوبة من حيث إن وجوب كل واحد منهما باعتبار حفظ الاراضي وإنزالها، إلا أن في الخراج معنى الذل على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى آلة الزراعة في دار قوم فقال: ما دخل هذا في دار قوم إلا ذلوا وكأن ذلك لما في الاشتغال بالزراعة من الاعراض عن الجهاد، وإنما يلتزم الخراج من يشتغل بعمل الزراعة، ولهذا لا يبتدأ المسلم بالخراج في أرضه ويبقى عليه الخراج بعد إسلامه، لانه يتردد بين المئونة والعقوبة فلا يمكن إيجابه على المسلم ابتداء لمعنى المئونة لمعارضة معنى العقوبة إياه، ولا يمكن إسقاطه
بعد الوجوب إذا أسلم باعتبار معنى العقوبة لمعارضة معنى المئونة إياه.
وأما العشر
ففيه معنى العبادة على معنى أنه مصروف إلى الفقير كالزكاة، وقد بينا أن بواسطة هذا المصروف يثبت فيه معنى القربة وإن كان وجوبه باعتبار مئونة الارض، ولهذا يجب في الاراضي النامية من غير اشتراط المالك لها نحو الاراضي الموقوفة وأرض المكاتب، ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا تحولت الارض العشرية إلى ملك الذمي تصير خراجية، لان فيها معنى العبادة والكافر ليس من أهل العبادة أصلا، وكل واحد منهما واجب بطريق المئونة فعند تعذر أحدهما يتعين الآخر، والخراج يبقى وظيفة الارض بعد انتقال الملك فيها إلى المسلم، لان المسلم من أهل أن توجب عليه المئونة التي فيها معنى العقوبة، فإنه بعد الاسلام أهل لالزام العقوبة عند تقرر سببها منه، والكافر ليس بأهل العبادة أصلا، فالاهلية للعبادة تبتنى على الاهلية لثوابها.
وقال أبو يوسف رحمه الله: يتضاعف العشر على الكافر اعتبارا بالصدقات المضاعفة في حق بني تغلب.
وأبى هذا أبو حنيفة رحمه الله، لان التضعيف حكم ثابت بخلاف القياس بإجماع الصحابة في قوم بأعيانهم، وغيرهم من الكفار ليسوا بمنزلتهم، فأولئك لا تؤخذ منهم الجزية، وغيرهم من الكفار تؤخذ منهم الجزية.
ومحمد رحمه الله يقول: تبقى عشرية كما كانت، لان البقاء باعتبار معنى المئونة كالخراج في حق المسلم.
ثم عنه روايتان في مصرف هذا العشر: في إحداهما يصرف إلى المقاتلة كالخراج لاعتبار معنى المئونة الخالصة (وفي الاخرى تكون مصروفة إلى الفقراء والمساكين، لانها لما بقيت باعتبار معنى المئونة تبقى) على ما كانت مصروفة إلى من كانت مصروفة إليه قبل هذا كالخراج في حق المسلم.
وأما الحق القائم بنفسه فنحو خمس الغنائم والمعادن والركاز، فإنه لا يكون واجبا ابتداء على أحد، ولكن باعتبار الاصل الغنيمة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: (قل الانفال لله) وهذا لانها أصيبت لاعلاء كلمة الله تعالى، إلا أن
الله تعالى جعل أربعة أخماسها للغانمين على سبيل المنة عليهم، فبقي الخمس له كما
كان في الاصل مصروفا إلى من أمر بالصرف إليه.
وكذلك خمس المعادن فإن الموجود ما كان لاحد فيه حق، فجعل الشرع أربعة أخماسه للواجد وبقي الخمس لله مصروفا إلى من أمر بالصرف إليه، ولهذا جاز وضع خمس الغنيمة فيمن هو من جملة الغانمين عند حاجتهم، وفي آبائهم وأولادهم، وجاز وضع خمس المعدن في الواجد عند الحاجة، فعرفنا أنه ليس بواجب عليه بل هو حق الله تعالى قائم كما كان، ولهذا جاز صرفه إلى بني هاشم، لان باعتبار هذا المعنى لا يتمكن فيه معنى الاوساخ بخلاف الصدقات، وأمر الله بصرف البعض منه إلى ذوي القربى، وكان ذلك عندنا باعتبار النصرة المخصوصة التي تحققت منهم بالانضمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال ما هجره الناس، ودخول الشعب معه لمؤانسته والقيام بنصرته، فإن ذلك كان فعلا من جنس القربة، فيجوز أن يتعلق به استحقاق ما هو صلة ومنة من الله تعالى كاستحقاق أربعة الاخماس، فأما القرابة خلقة لا تستحق بذاتها مال الله تعالى، ثم صيانة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استحقاق عوض مالي بمقابلتها أولى من إثبات الاستحقاق بسبب القرابة.
ولا يجوز جعل القرابة قرينة للنصرة أو النصرة قرينة للقرابة، لما بينا أن الترجيح إنما يكون بما لا يصلح علة بانفرادها للاستحقاق دون ما يصلح لذلك.
وعلى هذا الاصل استحقاق المصاب من الغنيمة وتمامه يكون بالاحراز بالدار بعد الاخذ.
والمسائل على هذا الاصل يكثر تعدادها إذا تأملت، وذلك معلوم فيما أملينا من فروع الفقه.
فأما العقوبات المحضة فهي الحدود التي شرعت زواجر عن ارتكاب أسبابها
المحظورة حقا لله تعالى خالصا، نحو حد الزنا والسرقة وشرب الخمر.
أما العقوبة القاصرة فنحو حرمان الميراث بسبب مباشرة القتل المحظور، فإنها عقوبة ولكنها قاصرة حتى تثبت في حق الخاطئ والنائم إذا انقلب
على مورثه، ولا تثبت في حق الصبي والمجنون عندنا أصلا، لانها عقوبة والاهلية للعقوبة لا تسبق الخطاب، بخلاف الخاطئ إذا كان بالغا عاقلا، فالبالغ العاقل مخاطب ولكنه بسبب الخطأ يعذر مع نوع تقصير منه في التحرز، والصبي لا يوصف بالتقصير الكامل والناقص فلا يثبت في حقه ما يكون عقوبة قاصرة كانت أو كاملة، ولهذا لا تثبت في حق القائد والسائق والشاهد إذا رجع عن شهادته، وحافر البئر وواضع الحجر، لانه جزاء على مباشرة القتل المحظور، والموجود من هؤلاء تسبب لا مباشرة.
وعند الشافعي هذا ضمان يتعلق بهذا الفعل بمنزلة الدية، فيثبت في حق المسبب والمباشر جميعا وفي حق الصبي والبالغ، وهذا غلط بين، لان الضمان ما يجب جبرانا لحق المتلف عليه ويسقط باعتبار رضاه أو عفو من يقوم مقامه، وحرمان الميراث ليس من ذلك في شئ.
فأما الدائر بين العبادة والعقوبة كالكفارات، لانها ما وجبت إلا جزاء على أسباب توجد من العباد، فسميت كفارة باعتبار أنها ستارة للذنب، فمن هذا الوجه عقوبة فإن العقوبة هي التي تجب جزاء على ارتكاب المحظور الذي يستحق المأثم به، وهي عبادة من حيث إنها تجب بطريق الفتوى ويؤمر من عليه بالاداء بنفسه من غير أن تقام عليه كرها، والشرع ما فوض إقامة شئ من العقوبات إلى المرء على نفسه، وتتأدى بما هو محض العبادة.
فعرفنا أنها دائرة بين العبادة والعقوبة، وأن سببها دائر بين الحظر والاباحة كاليمين المعقودة على أمر في المستقبل والقتل بصفة الخطأ، ولهذا لم نجعل الغموس
والعمد المحض سببا لوجوب الكفارة.
وعند الشافعي رحمه الله هذه الكفارات وجوبها بطريق الضمان، وقد بينا أن هذا غلط، ووجوب الضمان في الاصل بطريق الجبران وذلك لا يتحقق فيما يخلص لله تعالى، لان الله تعالى يتعالى عن أن يلحقه خسران حتى تتحقق الحاجة إلى الجبران، وكان معنى العبادة في هذه الكفارات مرجحا على معنى العقوبة كما أشرنا إليه، وتكفير الاثم به باعتبار أنه طاعة وحسن في نفسه، قال تعالى: (إن الحسنات
يذهبن السيئات) ولهذا أوجبنا الكفارة على المخطئ والمكره والبار في اليمين والحنث جميعا بأن حلف لا يكلم هذا الكافر فيسلم ثم يكلمه، ولهذا لم نوجب شيئا من هذه الكفارات على الكافر.
فأما كفارة الفطر في رمضان فمعنى العقوبة فيها مرجح على معنى العبادة حتى إن وجوبها يستدعي جناية متكاملة، عرفنا ذلك بخبر الاعرابي حيث قال هلكت وأهلكت.
وقال عليه السلام: من أفطر في رمضان متعمدا فعليه ما على المظاهر فاتفق العلماء على أنه يسقط بعذر الخطأ والاشتباه، فلما ظهر رجحان معنى العقوبة فيها من هذا الوجه جعلنا وجوبها بطريق العقوبة، فقلنا إنها تندرئ بالشبهات حتى لا تجب على من أفطر بعد ما أبصر هلال رمضان وحده للشبهة الثابتة بظاهر قوله عليه السلام: صومكم يوم تصومون أو بصورة قضاء القاضي يكون (اليوم) من شعبان، ولم يوجب على المفطر في يوم إذا اعترض مرض أو حيض في ذلك اليوم لتمكن الشبهة، ولم يوجب على من أفطر وهو مسافر وإن كان الاداء مستحقا عليه في ذلك الوقت بعينه بكونه مقيما في أول النهار، ولم يوجب على من نوى قبل انتصاف النهار ثم أفطر للشبهة الثابتة بظاهر قوله عليه السلام: لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل وقلنا بالتداخل
في الكفارات والاكتفاء بكفارة واحدة إذا أفطر في أيام من رمضان، لان التداخل من باب الاسقاط بطريق الشبهة، وأثبتنا معنى العبادة في الاستيفاء لانها سميت كفارة، فإنه يجوز أن يكون الوجوب بطريق العقوبة، والاستيفاء بطريق الطهرة كالحدود بعد التوبة، ولا يجوز أن يكون الوجوب بطريق العبادة والاستيفاء بطريق العقوبة بحال.
وما يجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب فنحو حد القذف عندنا.
فأما حد قطاع الطريق فهو خالص لله تعالى بمنزلة العقوبات المحضة، ولهذا لا نوجب على المستأمن إذا ارتكب سيئة في دارنا بمنزلة حد الزنا والسرقة بخلاف حد القذف.
وأما ما يجتمع فيه الحقان وحق العباد أغلب فنحو القصاص، فإن فيها حق الله تعالى، ولهذا يسقط بالشبهات، وهي جزاء الفعل في الاصل، وأجزية الافعال تجب لحق الله تعالى، ولكن لما كان وجوبها بطريق المماثلة عرفنا أن معنى حق العبد راجح فيها، وأن وجوبها للجيران بحسب الامكان كما وقعت الاشارة إليه في قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة) ولهذا جرى فيه الارث والعفو والاعتياض بطريق الصلح بالمال كما في حقوق العباد.
وأما ما يكون محض حق العباد فهو أكثر من أن يحصى نحو ضمان الدية وبدل المتلف والمغصوب وما أشبه ذلك.
وهذه الحقوق كلها تشتمل على أصل وخلف.
فالاصل فيما ثبت به الايمان التصديق والاقرار، ثم قد يكون الاقرار مستندا في حق المكره على أنه قائم مقام التصديق، ثم التصديق والاقرار من الابوين يثبت الايمان في حق الولد الصغير على أنه خلف عن التصديق والاقرار في حقه، ثم تبعية الدار في حق الذي سبى صغيرا وأخرج إلى دار الاسلام وحده حلف عن تبعية الابوين
في ثبوت حكم الايمان له، ثم تبعية السابي إذا قسم أو بيع من مسلم في دار الحرب خلف عن تبعية الدار في ثبوت حكم الايمان له حتى إذا مات يصلى عليه.
وكذلك في شرائط الصلاة، فإن من شرائطها الطهارة، والاصل فيه الوضوء أو الاغتسال، ثم التيمم يكون خلفا عن الاصل في حصول الطهارة التي هي شرط الصلاة به كما قال تعالى: (ولكن يريد ليطهركم) وهو خلف مطلق في قول علمائنا رحمهم الله.
وعند الشافعي رحمه الله هو خلف ضروري، ولهذا لم يعتبر التيمم قبل دخول الوقت في حق أداء الفريضة، ولم يجوز أداء الفريضتين بتيمم واحد لانه خلف ضروري فيشترط فيه تحقق الضرورة بالحاجة إلى إسقاط الفرض عن ذمته، وباعتبار كل فريضة تتجدد ضرورة أخرى، ولم يجوز التيمم للمريض الذي لا يخاف الهلاك على نفسه لان تحقق الضرورة عند خوف الهلاك على نفسه، وجوز التحري في إناءين أحدهما طاهر
والآخر نجس لان الضرورة لا تتحقق مع وجود الماء الطاهر عنده ومع رجاء الوصول إليه بالتحري فلا تكون فرضية التيمم وشرط طلب الماء لان الضرورة قبل الطلب لا تتحقق.
وعندنا هو بدل مطلق في حال العجز عن الاصل فثبت الحكم به على الوجه الذي يثبت بالاصل ما بقي عجزه.
ثم على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما التراب خلف عن الماء.
وعند محمد رحمه الله التيمم خلف عن الوضوء.
وتظهر المسألة في المتيمم: عند محمد لا يؤم المتوضئين لان التيمم خلف فكان المتيمم صاحب الخلف، وليس لصاحب الاصل القوي أن يبني صلاته على صلاة صاحب الخلف، كما لا يبني المصلي بركوع وسجود صلاته على صلاة المومي.
وعندهما التراب كان خلفا عن الماء في حصول الطهارة به ثم بعد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجودا في حق كل واحد منهما
بكماله بمنزلة الماسح يؤم الغاسلين لهذا المعنى، وقد يكون التيمم خلفا ضرورة في حال وجود الماء وهو أن يخاف فوات صلاة الجنازة أن لو اشتغل بالوضوء أو يخاف فوات صلاة العيد أن لو اشتغل بالوضوء.
ثم الخلافة هنا عند محمد بين التيمم والوضوء بطريق الضرورة حتى لو صلى عليها بالتيمم ثم جئ بجنازة أخرى يلزمه تيمم آخر وإن لم يجد بين الجنازتين من الوقت ما يمكنه أن يتوضأ فيه.
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله التراب خلف عن الماء فيجوز له أن يصلي على الجنائز ما لم يدرك من الوقت مقدار ما يمكنه أن يتوضأ فيه على وجه لا تفوته الصلاة على جنازة.
وهذا الذي بينا يتأتى في كل حق مما سبق ذكره إلا أن ببيان ذلك يطول الكتاب، والحاجة إلى معرفة الاصل هنا وهو أن الخلف يجب بما به يجب الاصل، وشرط كونه خلفا أن ينعقد السبب موجبا للاصل بمصادفته محله، ثم بالعجز عنه يتحول الحكم إلى الخلف، وإذا لم ينعقد السبب موجبا للاصل باعتبار أنه لم يصادف محله لا يكون موجبا للخلف حتى إن الخارج من البدن إذا لم يكن موجبا للوضوء كالدمع والبزاق والعرق لا يكون موجبا للتيمم، والطلاق قبل الدخول لما لم يكن موجبا لما هو الاصل وهو الاعتداد بالاقراء لا يكون موجبا لما هو خلف عنه وهو الاعتداد بالاشهر، واليمين الصادقة لما لم تكن موجبة للتكفير بالمال لا تكون موجبة لما هو
خلف عنه وهو التكفير بالصوم، واليمين الغموس عندنا لما لم تنعقد موجبة للاصل وهو البر باعتبار أنها أضيفت إلى محل ليس فيه تصور البر لا تنعقد موجبة لما هو خلف عنه وهو الكفارة، واليمين على مس السماء ونحوه لما انعقدت موجبة للبر لمصادفتها محلها كانت موجبة لما هو خلف عن البر وهو الكفارة، وقد تقدم بيان هذا فيمن أسلم في آخر الوقت بعدما بقي منه مقدار
ما لا يمكنه أن يصلي فيه، فإن الجزء الآخر من الوقت لما صلح أن يكون موجبا لاداء الصلاة صلح موجبا لما هو خلف عنه وهو القضاء.
وعلى هذا الاصل قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا جاء المشهود بقتله حيا أو رجع الشهود والولي جميعا بعد استيفاء القصاص فاختار ولي القتيل تضمين الشهود فإنهم يرجعون على الولي بما يضمنون، لان السبب وهو الضمان الذي لزمهم بطريق العدوان موجب للملك في المضمون، والمضمون وهو الدم مما يحتمل أن يكون مملوكا في الجملة، ألا ترى أن نفس من عليه القصاص في حكم القصاص كالمملوك لمن له القصاص، فإذا انعقد السبب موجبا للاصل لمصادفة محله ينعقد موجبا للخلف وهو الدية عند العجز عن إثبات ما هو الاصل وهو القصاص، بمنزلة من غصب مدبرا فغصبه منه آخر وأبق من يده، ثم ضمن المولى الغاصب الاول فإنه يرجع على الغاصب الثاني بالضمان وإن لم يملك المدبر، ولكن لما انعقد السبب موجبا للاصل بمصادفته محله يثبت الخلف قائما مقامه.
وكذلك شهود الكتابة ببدل مؤجل إذا رجعوا فضمنهم المولى قيمة المكاتب كان لهم أن يرجعوا على المكاتب ببدل الكتابة، لان السبب قد تقرر موجبا للاصل وهو الملك في المضمون لمصادفته محله فثبت (به الخلف)، وهو الرجوع ببدل الكتابة لوجود العجز عما هو الاصل، وهو ملك الرقبة باعتبار قيام الكتابة.
وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول قد وجد من الشهود التعدي بإتلاف النفس حكما ومن الولي التعدي بإتلاف النفس حقيقة والمساواة ثابتة بين الحكمي والحقيقي في حكم الضمان، ثم إذا اختار تضمين المتلف حقيقة
وهو الولي لم يرجع على الشهود بشئ، لانه ضمن بجنايته من حيث الاتلاف فكذلك إذا اختار تضمين الشهود قلنا لا يرجعون على الولي، لانهم ضمنوا
بجنايتهم، بخلاف ما إذا شهدوا بالقتل الخطأ وأخذ الولي الدية، لان وجوب الضمان هناك باعتبار تملك المال على من ألزمه القاضي الدية، فإذا ضمن الولي كان هو المتملك والمملوك سالم له، وإذا ضمن الشهود كانوا هم الذين تملكوا والمملوك في يد المولى أو قد صرفه إلى حاجته فيرجعون عليه بما ملكوه لهذا المعنى.
قولهما إن السبب هنا انعقد موجبا للاصل، ممنوع، لان الدم لا يملك بالضمان بحال، وفي القصاص الذي قالا الولي لا يملك نفس من عليه القصاص وإنما يستوفيه بطريق الاباحة، ولهذا لم يكن له حق الاستيفاء في الحرم، ولا يتحول حقه إلى البدل إذا قتل من عليه القصاص ظلما وإذا لم يكن محلا للملك عرفنا أن السبب ما انعقد موجبا للاصل، ولو كان الدم بمحل أن يملك لم يكن إيجاب الضمان للشهود على الولي أيضا، لانه صار متلفا عليهم ملك الدم، وإتلاف ملك الدم لا يوجب الضمان سواء أتلفه حقيقة أو حكما، ألا ترى أن من قتل من عليه القصاص فإنه لا يضمن لمن له القصاص شيئا.
وكذلك شهود العفو إذا رجعوا أو المكره على العفو لا يضمن أحد منهم شيئا، وإن أتلف ملك الدم الثابت لمن له القصاص، وبه فارق المدبر والمكاتب، لان هناك ما هو الاصل وهو ملك الرقبة في الموضع الذي يكون ثابتا يكون موجبا ضمان خلفه عند الاتلاف، فكذلك إذا انعقد السبب موجبا للاصل ثم لم يعمل لعارض وهو التدبير والكتابة قلنا يكون موجبا لما هو خلفه وهو القيمة وبدل الكتابة فيرجع بهما.
فصل: في بيان الكلام في القسم الثاني وهو السبب أما الكلام في القسم الثاني فنقول: تفسير السبب لغة: الطريق إلى الشئ
قال تعالى: (وآتيناه من كل شئ سببا فأتبع سببا) أي طريقا.
وقيل هو بمعنى الباب، قال تعالى: (لعلي أبلغ الاسباب أسباب السموات) : أي أبوابها، ومنه قول زهير: ولو نال أسباب السماء بسلم أي أبوابها.
وقيل هو بمعنى الحبل، قال تعالى: (فليمدد بسبب إلى السماء) الآية يعني بحبل من سقف البيت، فالكل يرجع إلى معنى (واحد) وهو طريق الوصول إلى الشئ.
وفي الاحكام السبب: عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم المطلوب من غير أن يكون الوصول به ولكنه طريق الوصول إليه، بمنزلة طريق الوصول إلى مكة، فإن الوصول إليها يكون بمشي الماشي وفي ذلك الطريق لا بالطريق، ولكن يتوصل إليها من ذلك الطريق عند قصد الوصول إليها.
وكذلك الحبل، فإنه طريق للوصول إلى قعر البئر أو إلى الماء الذي في البئر ولكن لا بالحبل بل بنزول النازل أو استقاء النازح بالحبل.
وأما تفسير العلة فهي: المغيرة بحلولها حكم الحال، ومنه سمي المرض علة لان بحلولها بالشخص يتغير حاله، ومنه يسمى الجرح علة لان بحلوله بالمجروح يتغير حكم الحال.
وقيل العلة: حادث يظهر أثره فيما حل به لا عن اختبار منه، ولهذا سمي الجرح علة، ولا يسمى الجارح علة، لانه يفعل عن اختيار، ولانه غير حال بالمجروح.
وفي أحكام الشرع العلة معنى في النصوص وهو تغير حكم الحال بحلوله بالمحل يوقف عليه بالاستنباط، فإن قوله عليه السلام: الحنطة بالحنطة مثلا بمثل غير حال بالحنطة ولكن في الحنطة وصف هو حال بها وهو كونه مكيلا مؤثرا في المماثلة ويتغير حكم الحال بحلوله فيكون علة لحكم الربا فيه، حتى إنه لما لم يحل
القليل الذي لا يدخل تحت الكيل لا يتغير حكم العقد فيه بل يبقى بعد هذا النص على ما كان عليه قبله.
وكذلك البيع علة للملك شرعا، والنكاح علة للحل شرعا، والقتل العمد علة لوجوب القصاص شرعا، باعتبار أن الشرع جعلها موجبة لهذه الاحكام، وقد بينا أن العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتها وأنه لا موجب إلا الله إلا أن ذلك الايجاب غيب في حقنا فجعل الشرع الاسباب التي يمكننا الوقوف عليها علة لوجوب الحكم في حقنا للتيسير علينا، فأما في حق الشرع فهذه العلل لا تكون موجبة شيئا، وهو نظير الاماتة، فإن المميت والمحيي هو الله تعالى حقيقة ثم جعله مضافا إلى القاتل بعلة القتل فيما ينبني عليه من الاحكام.
وكذلك أجزية الاعمال، فإن المعطي للجزاء هو الله تعالى بفضله ثم جعل ذلك مضافا إلى عمل العامل بقوله تعالى: (جزاء بما كانوا يعملون) فهذا هو المذهب المرضي التوسط بين الطريقين، لا كما ذهب إليه الجبرية من إلغاء العمل أصلا، ولا كما ذهب إليه القدرية من الاضافة إلى العمل حقيقة وجعل (العامل) مستبدا بعمله.
ثم هذه العلل الشرعية تسمى نظرا، وتسمى قياسا، وتسمى دليلا أيضا على معنى أنه يوقف به على معرفة الحكم، والدليل على الشئ ما يوقف به على معرفته كالدخان دليل على النار، والبناء دليل على الباني، ولكن ما يكون علة يجوز أن يسمى دليلا، وما يكون دليلا محضا لا يجوز أن يسمى علة، ألا ترى أن حدوث الاعراض دليل على حدوث الاجسام ولا يجوز أن يقال إنها علة لحدوث الاجسام، والمصنوعات دليل على الصانع ولا يجوز أن يقال إنها علة للصانع تعالى، فعرفنا أن الدليل قط لا يكون علة، وقد تكون العلة دليلا.
وأما الشرط فمعناه لغة: العلامة اللازمة، ومنه يقال أشراط الساعة:
أي علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة، ومنه الشرطي لانه نصب نفسه على زي وهيئة لا يفارقه ذلك في أغلب أحواله فكأنه لازم له، ومنه شرط الحجام لانه يحصل بفعله في موضع المحاجم علامة لازمة، ومنه الشروط في الوثائق لانها تكون لازمة، فعرفنا أن الشرط في اللغة: العلامة اللازمة، ومنه سمى أهل اللغة حرف إن حرف الشرط، من قول القائل لغيره: إن أكرمتني أكرمتك، فإن قوله أكرمتك بصيغة الفعل الماضي، ولكن بقوله إن أكرمتني يصير إكرام المخاطب علامة لازمة لاكرام المخاطب إياه، فكان شرطا من هذا الوجه.
وفي أحكام الشرع (الشرط) اسم لما يضاف الحكم إليه وجودا عنده لا وجوبا به، فإن قول القائل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، يجعل دخول الدار شرطا حتى لا يقع الطلاق بهذا اللفظ إلا عند الدخول، ويصير الطلاق عند وجود الدخول مضافا إلى الدخول موجودا عنده لا واجبا به، بل الوقوع بقوله أنت طالق عند الدخول، ومن حيث إنه لا أثر للدخول في الطلاق من حيث الثبوت به ولا من حيث الوصول إليه لم يكن الدخول سببا ولا علة، ومن حيث إنه مضاف إليه وجودا عنده كان الدخول شرطا فيه، ولهذا لا نوجب الضمان على شهود الشرط بحال، وإنما نوجب الضمان على شهود التعليق بعد وجود الشرط إذا رجعوا.
وقد يقام الشرط مقام السبب في حكم الضمان عند تعذر إضافة الاتلاف إلى السبب نحو حافر البئر على الطريق يكون ضامنا لما يسقط فيه، وهو صاحب الشرط من حيث إنه أزال بفعله المسكة عن الارض وهو محل يستقر فيه الثقيل، والمحال في حكم الشروط ولكن لما
تعذر إضافة الاتلاف إلى ما هو السبب حقيقة وهو ثقل الماشي ومشبه جعل مضافا إلى الشرط في حكم الضمان، حتى لو دفع الواقع في البئر إنسان فإن الضمان يكون على الدافع دون الحافر، لان السبب هنا صالح لاضافة الاتلاف إليه.
وسنقرر هذا في فصل الشرط، إن شاء الله تعالى.
أما العلامة لغة فهي: المعرف بمنزلة الميل والمنارة، والميل علامة الطريق لانه معرف له، والمنارة علامة الجامع لانها معرفة له، ومنه سمي المميز بين الارضين من المسناة منار الارض، قال عليه السلام: لعن الله من غير منار الارض: أي العلامة التي تعرف بها لتمييز بين الارضين.
وكذلك في أحكام الشرع: العلامة ما يكون معرفا للحكم الثابت بعلته من غير أن يكون الحكم مضافا إلى العلامة وجوبا لها لا وجودا عندها، على ما نبينه في فصل على حدة إن شاء الله تعالى.
فصل: في بيان تقسيم السبب قال رضي الله عنه: اعلم بأن أسباب الاحكام الشرعية أنواع أربعة: سبب صورة لا معنى وهو يسمى سببا مجازا، وسبب صورة ومعنى وهو يسمى سببا محضا، وسبب فيه شبهة العلة، وسبب هو بمعنى العلة.
وقد بينا أن السبب: ما هو طريق الوصول إلى الشئ.
فأما الذي يسمى السبب مجازا فنحو اليمين بالله تعالى: يسمى سببا للكفارة مجازا باعتبار الصورة، وهو ليس بسبب معنى، فإن أدنى حد السبب أن يكون طريقا للوصول إلى المقصود، والكفارة باليمين إنما تجب بعد الحنث، وهي مانعة من الحنث موجبة لضده وهو البر، فعرفنا أنه ليس بسبب للكفارة معنى قبل الحنث ولكن يسمى سببا مجازا، لانه طريق الوصول إلى وجوب
الكفارة بعد زوال المانع وهو البر وكذلك النذر المعلق بالشرط الذي لا يريد كونه، سبب لوجوب المنذور صورة لا معنى، لانه يقصد به منع ما يجب المنذور عند وجوده وهو إيجاد الشرط، وإنما يكون سببا بعد زوال المانع حقيقة.
وكذلك الطلاق والعتاق المعلق بالشرط، فإن التعليق سبب صورة لا معنى، لانه بالتعليق يمنع نفسه مما يقع الطلاق والعتاق عند وجوده.
وعلى هذا قلنا: التعليق بالملك صحيح وإن لم يكن الملك موجودا في الحال، لان المعلق ليس بطلاق ولا هو سبب الطلاق حقيقة ولكن يصير سببا عند وجود الشرط، وهذا لان الطلاق والعتاق لا يكون بدون المحل والتعليق يمنع الوصول إلى المحل.
وكذلك النذر، فإنه التزام في الذمة والتعليق يمنع وصول المنذور إلى الذمة، والتصرف بدون المحل لا يكون سببا كبيع الحر، إلا أن هناك ينعقد تصرف آخر وهو اليمين، لانه عقد مشروع لمقصود وفي ذلك المقصود التصرف صادف محله وهو ذمة الحالف، بخلاف بيع الحر فإنه لا ينعقد أصلا، وعلى هذا لا يجوز التكفير بعد اليمين قبل الحنث بالمال ولا بالصوم، لانها ليست بسبب للكفارة معنى، والاداء قبل تحقق السبب لا يجوز، بخلاف تعجيل الكفارة بعد الجرح قبل زهوق الروح في الآدمي والصيد، لانه سبب محض من حيث إنه طريق مفض إلى القتل عند زهوق الروح بالسراية، يوضحه أن اليمين لا تبقى بعد الحنث لانها مشروعة لمقصود وهو البر، وذلك يفوت بالحنث أصلا، والعقد لا يبقى بعد فوات مقصوده.
ولما كانت الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث الذي يرتفع به اليمين عرفنا أن اليمين ليست بسبب لها معنى إذ العقد لا يكون سببا للحكم الذي يثبت (بعد فسخه.
وكذلك اليمين بالطلاق، فإن الطلاق إنما يكون واقعا بما يبقى بعد وجود الشرط وهو قوله
أنت طالق، والنذر إنما يثبت) باعتبار ما يبقى بعد وجود الشرط وهو قوله على صوم أو صلاة، فعرفنا أن الموجود قبل وجود الشرط لا يكون سببا معنى، بخلاف كفارة القتل فإنه جزاء الفعل والفعل بالسراية يتقرر ولا يرتفع، فكان قبل السراية سببا وملك النصاب قبل كمال الحول هكذا، لانه يتقرر عنده ما لاجله كان النصاب سببا وهو معنى النمو، إلا أن مع هذا التعليق بالشرط لكونه سببا، مجازا أثبتنا فيه معنى السببية بوجه، بخلاف ما يقوله زفر رحمه الله إنه لا يثبت فيه حكم السببية بوجه.
وبيان هذا في تنجيز الثلاث بعد
صحة التعليق فإنه مبطل للتعليق عندنا، لان التعليق يمين وموجبه البر فإذا كان هذا السبب مضمونا (بالبر) كان له شبهة السببية في الحكم الذي يجب به بعد فوات البر على وجه الخلف عنه، كالغصب، فإنه موجب ضمان الرد في العين ثم له شبهة السببية في حكم ضمان القيمة الذي ثبت خلفا عن رد العين عند فوات العين، فكما يشترط قيام الملك وصفة الحل في المحل لبقاء ما هو سبب للحكم حقيقة فكذلك يشترط لبقاء ما فيه شبهة السببية للحكم، وتنجيز الثلاث يفوت ذلك كله.
وزفر يقول: ليس في التعليق شبهة السببية للحكم وهو الطلاق والعتاق وإنما هو تصرف آخر وهو اليمين محلها الذمة واشتراط الملك في المحل عند انعقاده ليترجح جانب الوجود على جانب العدم حتى يصح إيجاب اليمين به، وهذا غير معتبر في حال البقاء، ألا ترى أن بعد التطليقات الثلاث لو علق الطلاق ابتداء بالنكاح كان صحيحا، وصفة الحل الذي به يصير المحل محلا للطلاق معدوم أصلا.
ولكنا نقول: الملك سبب هو في معنى العلة، فإن النكاح علة لملك الطلاق، فالتطليق بمنزلة سبب هو في معنى العلة، على ما نبينه إن شاء الله تعالى، فأما الاضافة إلى وقت لا تعدم السببية معنى
كما يعدمه التعليق بالشرط، ولهذا قلنا في قوله تعالى: (فعدة من أيام أخرى) : إنه لا يخرج شهود الشهر من أن يكون سببا حقيقة في حق جواز الاداء.
وقوله تعالى: (وسبعة إذا رجعتم) يخرج المتمتع من أن يكون سببا لصوم السبعة قبل الرجوع من منى حتى لو أداه لا يجوز، لانه لما تعلق بشرط الرجوع فقبل وجود الشرط لا يتم سببه معنى، وهناك إضافة الصوم إلى وقت فقبل وجود الوقت يتم السبب فيه معنى حتى يجوز الاداء.
وأما السبب المحض وهو: ما يكون طريقا للوصول إلى الحكم ولكن
لا يضاف الحكم إليه وجوبا به ولا وجودا عنده بل تتخلل بين السبب والحكم العلة التي يضاف الحكم إليها وتلك العلة غير مضافة إلى السبب، وذلك نحو حل قيد العبد، فإنه طريق لوصول العبد إلى الاباق الذي هو متو مالية المولى فيه، ولكن يتخلل بينه وبين الاباق الذي تتوى به المالية قصد وذهاب من العبد وهو غير مضاف إلى السبب السابق، فيبقى حل القيد سببا محضا.
وعلى هذا قلنا: لو فتح باب الاصطبل فندت الدابة أو باب القفص فطار الطير لم يجب الضمان عليه، لان العلة قوة الدابة في نفسها على الذهاب وقوة الطير على الطيران، وهو غير مضاف إلى السبب الاول.
وكذلك لو دل إنسانا على مال الغير فأتلفه أو على نفسه فقتله أو على قافلة حتى قطع الطريق عليهم لم يكن ضامنا شيئا، لان الدلالة سبب محض من حيث إنه طريق الوصول إلى المقصود، ويتخلل بينه وبين حصول المقصود ما هو علة وهو غير مضاف إلى السبب الاول، وذلك الفعل الذي يباشره المدلول.
وعلى هذا قلنا: لو قال لرجل هذه المرأة حرة فتزوجها، فذهب وتزوجها واستولدها ثم ظهر أنها كانت أمة فإنه لا يرجع بضمان قيمة الاولاد
على المخبر، بخلاف ما إذا زوجها منه على أنها حرة، لان إخباره سبب للوصول إلى المقصود، ولكن تخلل بينه وبين المقصود وهو الاستيلاد ما هو علة فهو غير مضاف إلى السبب الاول، وذلك عقد النكاح الذي باشرته المرأة على نفسها.
وعلى هذا قلنا: الموهوب له الجارية إذا استولدها ثم استحقت لم يرجع بقيمة الاولاد على الواهب، والمستعير إذا أتلف العين باستعماله ثم ظهر الاستحقاق لم يرجع بالقيمة على المعير، لان الهبة والاعارة سبب ولكن تخلل بينه وبين حصول الاولاد ما هو علة وهو الاستيلاد والاستعمال المفضي إلى التلف، وذلك غير مضاف إلى السبب الاول، بخلاف المشتري إذا استولدها ثم ظهر الاستحقاق فإنه يرجع بقيمة الاولاد، لان بمباشرة عقد الضمان قد التزم له صفة السلامة عن العيب، ولا عيب فوق الاستحقاق، وبمباشرة عقد التبرع لا يصير ملتزما سلامة المعقود عليه عن العيب، ولهذا لا يرجع بالعقد في الوجهين لانه لزمه بدلا عما استوفاه ولا رجوع
له بسبب العيب فيما استوفاه لنفسه، وإن كان البائع ضمن له صفة السلامة عن العيب.
وزعم بعض أصحابنا أن رجوع المغرور باعتبار الكفالة وذلك باشتراط البدل، فإن البائع يصير كأنه قال ضمنت لك سلامة الاولاد على أنه إن لم يسلم لك فأنا ضامن لك ما يلزمك بسببه.
وهذا الضمان لا يثبت في عقد التبرع وإنما يثبت في حق الضمان باشتراط البدل إلا أن الاول أصح.
وقد قال في كتاب العارية: العبد المأذون إذا آجر دابة فتلفت باستعمال المستأجر ثم ظهر الاستحقاق رجع المستأجر بما ضمن من قيمتها على العبد في الحال، والعبد لا يؤاخذ بضمان الكفالة ما لم يعتق، وهو مؤاخذ بالضمان الذي يكون سببه العيب بعدما التزم صفة السلامة عن العيب بعقد الضمان.
ولا يدخل
على ما قلنا دلالة المحرم على قتل الصيد، فإنها توجب عليه ضمان الجزاء وهي سبب محض لا يتخلل بينها وبين المقصود ما هو العلة وهو القتل من المدلول، وهذا لان وجوب الضمان عليه بجنايته بإزالة الامن عن الصيد، فإن أمنه في البعد عن أيدي الناس وأعينهم، وقد التزم بعقد الاحرام الامن للصيد عنه، فإذا صار بالدلالة جانيا من حيث إزالته الامن كان ضامنا لذلك، إلا أن قبل القتل لا يجب عليه الضمان لبقاء التردد، فقد يتوارى الصيد على وجه لا يقدر المدلول عليه فيعود آمنا كما كان، فبالقتل تستقر جنايته بإزالة الامن.
فهو نظير الجراحة التي يتوهم فيها الاندمال بالبرء على وجه لا يبقى لها أثر، فإنه يستأني فيها مع كون الجرح جناية، ولكن لبقاء التردد يستأني حتى يتقرر حكمها في حق الضمان، بخلاف الدلالة على مال الغير، فإن حفظ الاموال بالايدي لا بالبعد عن الايدي والاعين، فالدال لا يصير جانيا بإزالة الحفظ بدلالته، وهذا بخلاف المودع إذا دل سارقا على سرقة الوديعة فإنه يصير ضامنا، لانه جان بترك ما التزمه من الحفظ بعقده وهو ترك التضييع وبالدلالة يصير مضيعا، فهو نظير المحرم يدل على قتل الصيد حتى يصير ضامنا لتركه ما التزمه بالعقد وهو أمن الصيد عنه.
وعلى هذا قلنا: من أخرج ظبية من الحرم فولدت فهو ضامن للولد لانها بالحرم آمنة، وثبوت يده عليها يفوت معنى الصيدية، فيثبت به معنى إزالة الامن في حق الولد،
بخلاف الغاصب فإنه لا يكون ضامنا للزوائد لان الاموال محفوظة بالايدي، فإنما يجب الضمان هنا بالغصب الذي هو موجب قصر يد المالك عن ماله، وذلك غير موجود في الزيادة مباشرة ولا تسبيبا، ولا ينكر كونه متعديا في إمساك الولد، ولهذا نجعله آثما ونوجب عليه رده.
ولكنا نقول: هو ليس بغاصب
للولد تسبيبا ولا مباشرة، وبتعد آخر سوى الغصب لا يوجب ضمان الغصب، واليد الثابتة على الام عند انفصال الولد عنها حكم الغصب لا نفس الغصب، فعرفنا أنه لم يثبت الغصب في الولد بطريق السراية ولا قصدا بطريق المباشرة ولا بطريق التسبب بغصب الام، لان قصر يد المالك تكون بإزالة يده عما كان في يده، أو بإزالة تمكنه من أخذ ما لم يكن في يده، وذلك غير موجود في الولد أصلا قبل أن يطالبه بالرد.
ومن السبب المحض أن يدفع سكينا إلى صبي فيجأ الصبي به نفسه، فإنه لا يجب على الدافع ضمان وإن كان فعله بعلة طريق الوصول، ولكن قد تخلل بينه وبين المقصود ما هو علة وهو غير مضاف إلى السبب الاول، وذلك قتل الصبي به نفسه، بخلاف ما إذا سقط من يده على رجله فعقره، لان السقوط من يده مضاف إلى السبب الاول وهو مناولته إياه، فكان هذا سببا في معنى العلة، على ما نبينه إن شاء الله تعالى.
وكذلك لو أخذ صبيا حرا من يد وليه فمات في يده بمرض لم يضمن الآخذ شيئا، بخلاف ما إذا قربه إلى مسبعة حتى افترسه سبع، فإن السبب هنا بمعنى العلة باعتبار الاضافة إليه، فإنه يقال لولا تقريبه إياه من هذه المسبعة ما افترسه السبع، ولا يقال لولا أخذه من يد وليه لم يمت من مرضه.
ولو قتل الصبي في يد الآخذ رجلا فضمن عاقلته الدية لم يرجعوا به على عاقلة الآخذ، لانه تخلل بين السبب ووجوب الضمان عليهم ما هو علة وهو غير مضاف إلى ذلك التسبيب.
وعلى هذا لو قال لصبي: ارق هذه الشجرة فانفضها لي، فسقط كان ضامنا، بخلاف ما لو قال: كل ثمرتها أو فانفضها لنفسك، لان كلامه تسبيب قد تخلل بينه وبين السقوط ما هو علة وهو صعود الصبي الشجرة لمنفعة نفسه، وفي الاول لما كان صعوده لمنفعة الآمر صار بسببه في معنى العلة بطريق