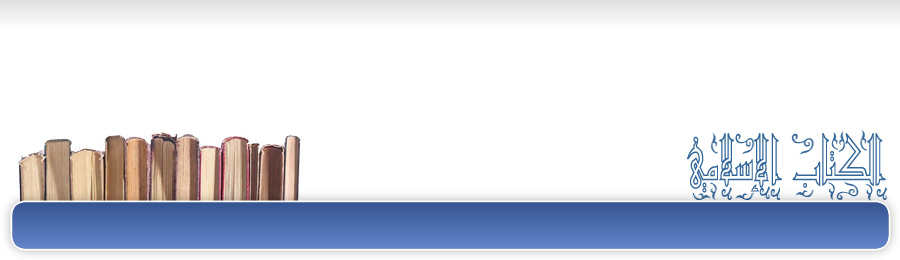الكتاب : أصول السرخسي
المؤلف : ابى بكر محمد بن احمد بن ابى سهل السرخسى
مضموما إلى القذف ليتحقق بهما السبب الموجب للعقوبة، كما هو موجب حرف ثم فإنه للتعقيب مع التراخي، وجعلنا الواو في قوله تعالى: (ولا تقبلوا) للعطف فكان رد الشهادة متمما للحد كما هو موجب واو العطف، وجعلنا الواو في قوله تعالى: (وأولئك) للنظم كما هو مقتضى صيغة الكلام.
والشافعي ترك العمل بحرف ثم وجعل نفس القذف موجبا للحد، وجعل الواو في قوله تعالى: (ولا تقبلوا) للنظم، وفي قوله: (وأولئك) للعطف وكل ذلك مخالف لمقتضى صيغة الكلام، فكان الصحيح ما قلناه.
ومن هذه الجملة حكم الجمع المضاف إلى جماعة نحو قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) وقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) فإن من الناس من يقول حكمة حقيقة الجماعة في حق كل واحد ممن أضيف إليهم وزعموا أن حقيقة الكلام هذا فإن المضاف إلى جماعة يكون مضافا إلى كل واحد منهم، وإذا كانت الصيغة التي بها حصلت الاضافة صيغة الجماعة وبها يثبت الحكم في كل واحد منهم ما هو مقتضى هذه الصيغة قولا بحقيقة الكلام، ألا ترى أن الاضافة لو حصلت بصيغة الفرد تثبت في كل واحد منهم الحكم الذي هو موجب تلك الصيغة.
وعندنا هذا فاسد وهو من جنس القول بالمسكوت، ولكن مقتضى هذه الصيغة مقابلة الآحاد بالآحاد على ما قال في الجامع: إذا قال لامرأتين له إذا ولدتما ولدين فأنتما طالقان فولدت كل واحدة منهما ولدا طلقتا، وكذلك إذا قال إذا حضتما حيضتين أو قال إذا دخلتما هاتين الدارين فدخلت كل واحدة منهما دارا فهما طالقان، ولا يشترط دخول كل واحدة منهما في الدارين جميعا، وما قلناه هو المعلوم من مخاطبات الناس، فإن الرجل يقول لبس
القوم ثيابهم وحلقوا رؤوسهم وركبوا دوابهم، وإنما يفهم من ذلك أن كل واحد منهم لبس ثوبه وركب دابته وحلق رأسه، والدليل عليه قول الشاعر: وإنا نرى أقدامنا في نعالهم وآنفنا بين اللحى والحواجب والمراد ما قلنا وكتاب الله يشهد به، قال تعالى: (جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم) والمراد أن كل واحد منهم جعل أصبعه في أذنه لا في آذان الجماعة واستغشى ثوبه، وقال تعالى: (فقد صغت قلوبكما) والمراد في حق كل
واحدة منهما قلبها، وقال تعالى: (فاقطعوا أيديهما) والمراد قطع يد واحدة من كل واحد منهما لا قطع جميع ما يسمى يدا من كل واحد منهما لاتفاقنا على أن بالسرقة الواحدة لا تقطع إلا يد واحدة من السارق، وقد بينا أن مطلق الكلام محمول على ما يتفاهمه الناس في مخاطباتهم فهو اعتبار الصيغة بدون الاضافة، والمنصوص عليه الصيغة مع الاضافة إلى الجماعة ومع الاضافة إلى الجماعة موجب الصيغة حقيقة ليس ما ادعوا بل موجبه ما قلنا، لان ما ادعوا يثبت بدون الاضافة إلى الجماعة (وما قلنا لا يثبت بدون الاضافة إلى الجماعة) فعرفنا أن حقيقة العمل بالمنصوص فيما قلنا، وفيما قالوا ترك العمل بالدليل المنصوص وعمل بالمسكوت فيكون فاسدا.
هذا بيان الطريق فيما هو فاسد من وجوه العمل بالمنصوص كما ذهب إليه بعض الناس، وقد بينا الطريق الصحيح من ذلك في أول الباب، فمن فهم الطريقين يتيسر عليه تمييز الصحيح من الاستدلال بجميع النصوص والفاسد، وإن خفي عليه شئ فهو يخرج بالتأمل على ما بينا من كل طريق، والله أعلم.
باب: بيان الحجة الشرعية وأحكامها قال رضي الله عنه: اعلم بأن الحجة لغة اسم من قول القائل: حج، أي غلب، ومنه يقال: لج فحج، ويقول الرجل: حاججته فحججته، أي ألزمته بالحجة فصار
مغلوبا، ثم سميت الحجة في الشريعة، لانه يلزمنا حق الله تعالى بها على وجه ينقطع بها العذر، ويجوز أن يكون مأخوذا من معنى الرجوع إليه، كما قال القائل: يحجون بيت الزبرقان المزعفرا أي يرجعون إليه، ومنه: حج البيت، فإن الناس يرجعون إليه معظمين له، قال تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) والمثابة المرجع فسميت الحجة لوجوب الرجوع إليها من حيث العمل بها شرعا، ويستوي إن كانت موجبة
للعلم قطعا أو كانت موجبة للعمل دون العلم قطعا، لان الرجوع إليها بالعمل بها واجب شرعا في الوجهين على ما نبينه في باب خبر الواحد والقياس إن شاء الله تعالى.
والبينة كالحجة فإنها مشتقة من البيان وهو أن يظهر للقلب وجه الالزام بها سواء كان ظهورا موجبا للعلم أو دون ذلك لان العمل يجب في الوجهين، ومنه قوله تعالى: (فيه آيات بينات) : أي علامات ظاهرات.
والبرهان كذلك فإنه مستعمل استعمال الحجة في لسان الفقهاء.
وأما الآية فمعناها لغة: العلامة، قال الله تعالى: (فيه آيات بينات) وقال القائل: وغير آيها العصر ومطلقها في الشريعة ينصرف إلى ما يوجب العلم قطعا، ولهذا سميت معجزات الرسل آيات، قال الله تعالى: (ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات) وقال تعالى: (فاذهبا بآياتنا) .
فإن قيل: من الناس من جحد رسالة الرسل بعد رؤية المعجزات والوقوف عليها ولو كانت موجبة للعلم قطعا لما أنكرها أحد بعد المعاينة ؟ قلنا: هذه الآيات لا توجب العلم خبرا فإنها لو أوجبت ذلك انعدم الثواب والعقاب بها أصلا وإنما توجب العلم باعتبار التأمل فيها عن إنصاف لا عن تعنت، ومع هذا التأمل يثبت العلم بها
قطعا وإنما جحدها من جحدها للاعراض عن هذا التأمل كما ذكر الله تعالى في قوله: (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه) وفي قوله: (لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه) وقد كان فيهم من جحد تعنتا بعدما علم يقينا كما قال تعالى: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) وأما الدليل فهو فعيل من فاعل الدلالة، بمنزلة عليم من عالم، ومنه قولهم: يا دليل المتحيرين، أي هاديهم إلى ما يزيل الحيرة عنهم، ومنه سمي دليل القافلة، أي هاديهم إلى الطريق فسمي باسم فعله، وفي الشريعة هو اسم لحجة منطق يظهر به ما كان خفيا فإن ما قدمناه يكون موجبا تارة ومظهرا تارة، والدليل خاص لما هو مظهر.
فإن قيل: أليس أن الدخان دليل على النار والبناء دليل على الباني ولا نطق
هناك ؟ قلنا: إنما يطلق الاسم على ذلك مجازا بحصول معنى الظهور عنده، كما قال تعالى: (قالتا أتينا طائعين) وقال تعالى: (فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه) وقال القائل: وعظتك أحداث صمت، وكل ذلك مجاز.
ثم الدليل مجازا كان أو حقيقة يكون مظهرا ظهورا موجبا للعلم به أو دون ذلك.
والشاهد كالدليل سواء كان مظهرا على وجه يثبت العلم به أو لا يثبت به علم اليقين بمنزلة الشهادات على الحقوق في مجالس الحكام.
قال رضي الله عنه: ثم اعلم بأن الاصول في الحجج الشرعية ثلاثة: الكتاب والسنة، والاجماع، والاصل الرابع وهو القياس هو المعنى المستنبط من هذه الاصول الثلاثة.
وهي تنقسم قسمين: قسم موجب للعلم قطعا، ومجوز غير موجب للعلم، وإنما سميناه مجوزا لانه يجب العمل به والاصل أن العمل بغير علم لا يجوز، قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) فسميناه مجوزا باعتبار أنه يجب العمل به وإن لم يكن موجبا للعلم قطعا.
فأما الموجب للعلم من الحجج الشرعية أنواع أربعة: كتاب الله،
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسموع منه والمنقول عنه بالتواتر، والاجماع.
والاصل في كل ذلك لنا السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي أسمعنا ما أوحي إليه من القرآن بقراءته علينا، والمنقول عنه بطريق متواتر بمنزلة المسموع عنه في وقوع العلم به على ما نبينه، وكذلك الاجماع فإن إجماع هذه الامة إنما كانت حجة موجبة للعلم بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يجمع أمته على الضلالة، والسماع منه موجب للعلم لقيام الدلالة على أن الرسول عليه السلام يكون معصوما عن الكذب والقول بالباطل.
فهذا بيان قولنا إن الاصل في ذلك كله السماع من رسول صلى الله عليه وسلم .
فصل: في بيان الكتاب وكونه حجة قال رضي الله عنه: اعلم بأن الكتاب هو القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، المكتوب في دفات المصاحف، المنقول إلينا على الاحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا، لان ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان ولا يثبت بمثله القرآن مطلقا، ولهذا قالت الامة لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته، لانه لم يوجد
فيه النقل المتواتر، وباب القرآن باب يقين وإحاطة فلا يثبت بدون النقل المتواتر كونه قرآنا، وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر فيكون مفسدا للصلاة.
فإن قيل: بكونه معجزا يثبت أنه قرآن بدون النقل المتواتر.
قلنا: لا خلاف أن ما دون الآية غير معجز، وكذلك الآية القصيرة، ولهذا لم يجوز أبو يوسف ومحمد رحمهما الله الصلاة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة لان المعجز السورة وأقصر السور ثلاث آيات يعني الكوثر.
وأبو حنيفة رحمه الله قال: الواجب بالنص قراءة ما تيسر من القرآن وبالآية القصيرة يحصل ذلك فيتأدى فرض القراءة وإن كان
يكره الاكتفاء بذلك، وجاء فيما ذكرنا أن ما دون الآية والآية القصيرة ليس بمعجز وهو قرآن يثبت به العلم قطعا، فظهر أن الطريق فيه النقل المتواتر مع أن كونه معجزا دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به، وليس بدليل في نفسه على أنه كلام الله لجواز أن يقدر الله تعالى رسوله على كلام يعجز البشر عن مثله، كما أقدر عيسى على إحياء الموتى، وعلى أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله.
فعرفنا أن الطريق فيه النقل المتواتر.
وإنما اعتبرنا الاثبات في دفات المصاحف لان الصحابة رضي الله عنهم إنما أثبتوا القرآن في دفات المصاحف لتحقيق النقل المتواتر فيه، ولهذا أمروا بتجريد القرآن في المصاحف وكرهوا التعاشير وأثبتوا في المصاحف ما اتفقوا عليه ثم نقل إلينا نقلا متواترا فثبت به العلم قطعا، ولما ثبت بهذا الطريق أنه كلام الله تعالى ثبت أنه حجة موجبة للعلم قطعا لعلمنا يقينا أن كلام الله لا يكون إلا حقا.
فإن قيل: فالتسمية نقلت إلينا مكتوبة في المصاحف بقلم الوحي لمبدأ الفاتحة ومبدأ كل سورة سوى سورة براءة، ثم لم تجعلوها آية من الفاتحة ولا من أول كل سورة مع النقل المتواتر من الوجه الذي قررتم ؟ قلنا: قد ذكر أبو بكر الرازي رحمه الله أن الصحيح من المذهب عندنا أن التسمية آية منزلة من القرآن لا من أول السورة ولا من آخرها ولهذا كتبت للفصل بين السور في المصحف بخط على حدة لتكون
الكتابة بقلم الوحي دليلا على أنها منزلة للفصل، والكتابة بخط على حدة دليلا على أنها ليست من أول السورة، وظاهر ما ذكر في الكتاب علماؤنا يشهد به فإنهم قالوا ثم يفتتح القراءة ويخفي بسم الله الرحمن الرحيم فقد قطعوا التسمية عن التعوذ وأدخلوها في القراءة، ولكن قالوا لا يجهر بها لانه ليس من ضرورة كونها آية من القرآن الجهر بها بمنزلة الفاتحة في الاخريين، وإنما قالوا يخفي بها ليعلم أنها ليست بآية من
أول الفاتحة فإن المتعين في حق الامام الجهر بالفاتحة والسورة في الاوليين، وعلى هذا نقول يكره للجنب والحائض قراءة التسمية على قصد قراءة القرآن، لان من ضرورة كونها آية من القرآن حرمة القراءة على الجنب والحائض، ولكن لا يتأدى بها فرض القراءة في الركعة عند أبي حنيفة رحمه الله لاشتباه الآثار واختلاف العلماء وأدنى درجات الاختلاف المعتبر إيراث الشبهة به، وما كان فرضا مقطوعا به لا يتأدى بما فيه شبهة، ولسنا نعني الشبهة في كونها من القرآن بل في كونها آية تامة فإنه لا خلاف في أنها من القرآن في قوله تعالى: (وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) .
فإن قيل: فقد أثبتم بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، كونه قرآنا في حق العمل به ولم يوجد فيه النقل المتواتر ولم تثبتوا في التسمية مع النقل المتواتر كونها آية من القرآن في حكم العمل وهو وجوب الجهر بها في الصلاة وتأدي القراءة بها.
قلنا: نحن ما أثبتنا بقراءة ابن مسعود كون تلك الزيادة قرآنا وإنما جعلنا ذلك بمنزلة خبر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمنا أنه ما قرأ بها إلا سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره مقبول في وجوب العمل به، وبمثل هذا الطريق لا يمكن إثبات هذا الحكم في التسمية، لان برواية الخبر وإن علم صحته لا يثبت حكم جواز الصلاة، ولانه ليس من ضرورة كونها آية من القرآن وجوب الجهر بها على ما بينا أن الفاتحة لا يجهر بها في الاخريين، وما كان ثبوته بطريق الاقتضاء يتقدر الحكم فيه بقدر الضرورة لانه لا عموم للمقتضى.
ثم قال كثير من مشايخنا إن إعجاز القرآن في النظم وفي المعنى جميعا خصوصا على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله حيث قالا: بالقراءة بالفارسية في الصلاة لا يتأدى فرض القراءة وإن كان مقطوعا به أنه هو المراد، لان الفرض قراءة المعجز وذلك في النظم والمعنى جميعا.
قال رضي الله عنه: والذي يتضح لي أنه ليس مرادهم من هذا أن
المعنى بدون النظم غير معجز، فالادلة على كون المعنى معجزا ظاهرة: منها أن المعجز كلام الله (وكلام الله تعالى) غير محدث ولا مخلوق والالسنة كلها محدثة العربية والفارسية وغيرهما، فمن يقول الاعجاز لا يتحقق إلا بالنظم فهو لا يجد بدا من أن يقول بأن المعجز محدث وهذا مما لا يجوز القول به، والثاني أن النبي عليه السلام بعث إلى الناس كافة (وآية نبوته القرآن الذي هو معجز فلا بد من القول بأنه حجة له على الناس كافة) ومعلوم أن عجز العجمي عن الاتيان بمثل القرآن بلغة العرب لا يكون حجة عليه فإنه يعجز أيضا عن الاتيان بمثل شعر امرئ القيس وغيره بلغة العرب وإنما يتحقق عجزه عن الاتيان بمثل القرآن بلغته، فهذا دليل واضح على أن معنى الاعجاز في المعنى تام، ولهذا جوز أبو حنيفة رحمه الله القراءة بالفارسية في الصلاة، ولكنهما قالا في حق من لا يقدر على القراءة بالعربية الجواب هكذا، وهو دليل على أن المعنى عندهما معجز فإن فرض القراءة ساقط عمن لا يقدر على قراءة المعجز أصلا ولم يسقط عنه الفرض أصلا بل يتأدى بالقراءة بالفارسية، فأما إذا كان قادرا على القراءة بالعربية لم يتأد الفرض في حقه بالقراءة بالفارسية عندهما لا لانه غير معجز ولكن لان متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف في أداء هذا الركن فرض في حق من يقدر عليه، وهذه المتابعة في القراءة بالعربية، إلا أن أبا حنيفة اعتبر هذا في كراهة القراءة بالفارسية فأما في تأدي أصل الركن بقراءة القرآن فإنه اعتبر ما قررناه.
فصل: في بيان حد المتواتر من الاخبار وموجبها المتواتر ما اتصل بنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل المتواتر.
مأخوذ من قول القائل: تواترت الكتب إذا اتصلت بعضها ببعض في الورود متتابعا، وحد ذلك أن ينقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم هكذا إلى أن يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيكون
أوله كآخره وأوسطه كطرفيه، وذلك نحو نقل أعداد الركعات وأعداد الصلوات
ومقادير الزكاة والديات وما أشبه ذلك، وهذا لان الاتصال لا يتحقق إلا بعد انقطاع شبهة الانفصال، وإذا انقطعت شبهة الانفصال ضاهى ذلك المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لان الناس على همم شتى، وذلك يبعثهم على التباين في الاهواء والمرادات، فلا يردهم عن ذلك إلى شئ واحد إلا جامع أو مانع، وليس ذلك إلا اتفاق صنعوه، أو سماع اتبعوه، فإذا انقطعت تهمة الاختراع لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم تعين جهة السماع، ولهذا كان موجبا علم اليقين عند جمهور الفقهاء.
ومن الناس من يقول الخبر لا يكون حجة أصلا.
ولا يقع العلم به بوجه، وكيف يقع العلم به والمخبرون هم الذين تولوا نقله ؟ وإنما وقوع العلم بما ليس من صنع البشر ويكون خارجا عن مقدورهم، فأما ما يكون من صنع البشر ويتحقق منهم الاجتماع على اختراعه قلوا أو كثروا فذلك لا يكون موجبا للعلم أصلا، هذا قول فريق ممن ينكر رسالة المرسلين، وهذا القائل سفيه يزعم أنه لا يعرف نفسه ولا دينه ولا دنياه ولا أمه ولا أباه، بمنزلة من ينكر العيان من السوفسطائية فلا يكون الكلام معه على سبيل الاحتجاج والاستدلال، فكيف يكون ذلك وما يثبت بالاستدلال من العلم دون ما ثبت بالخبر المتواتر ؟ فإن هذا يوجب علما ضروريا والاستدلال لا يوجب ذلك، وإنما الكلام معه من حيث التقرير عند العقلاء بما لا يشك هو ولا أحد من الناس في أنه مكابرة وجحد لما يعلم اضطرارا، بمنزلة الكلام مع من يزعم أنه لا حقيقة للاشياء المحسوسة.
فنقول: إذا رجع الانسان إلى نفسه علم أنه مولود اضطرارا بالخبر، كما علم أن ولده مولود بالمعاينة وعلم أن أبويه كانا من جنسه بالخبر كما علم أن أولاده من جنسه بالعيان، وعلم أنه كان صغيرا ثم شابا بالخبر، كما علم ذلك من ولده بالعيان، وعلم أن السماء والارض كانتا قبله على هذه الصفة بالخبر، كما يعلم أنهما على هذه الصفة للحال بالعيان، وعلم أن آدم
أبو البشر على وجه لا يتمكن فيه شبهة، فمن أنكر شيئا من هذه الاشياء فهو مكابر جاحد لما هو معلوم ضرورة بمنزلة من أنكر العيان.
ولا نقول: إن هذا العلم يحصل بفعل المخبرين بل بما هو من صنع الله تعالى، وهو أنه خلق الخلق أطوارا، على طباع مختلفة وهمم متباينة يبعثهم على ذلك الاختلاف والتباين، فالاتفاق بعد ذلك مع الاسباب الموجبة للاختلاف لا يكون إلا بجامع يجمعهم على ذلك كما قررنا، وفيه حكمة
بالغة وهو بقاء الاحكام بعد وفاة المرسلين على ما كانت عليه في حياتهم، فإن النبوة ختمت برسولنا صلى الله عليه وسلم وقد كان مبعوثا إلى الناس كافة وقد أمرنا بالرجوع إليه والتيقن بما يخبر به، قال تعالى: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) وهذا الخطاب يتناول الموجودين في عصره والذين يؤمنون به إلى قيام الساعة، ومعلوم أن الطريق في الرجوع إليه ليس إلا الرجوع إلى ما نقل عنه بالتواتر، فبهذا يتبين أن هذا كالمسموع منه في حياته، وقد قامت الدلالة على أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالحق خصوصا فيما يرجع إلى بيان الدين، فيثبت منه بالسماع علم اليقين.
ومن الناس من يقول إن ما يثبت بالتواتر علم طمأنينة القلب لا علم اليقين، ومعنى هذا أنه يثبت العلم به مع بقاء توهم الغلط أو الكذب ولكن لرجحان جانب الصدق تطمئن القلوب إليه فيكون ذلك علم طمأنينة مثل ما يثبت بالظاهر لا علم اليقين.
قالوا لان التواتر إنما يثبت بمجموع آحاد، ومعنى احتمال الكذب ثابت في خبر كل واحد من تلك الآحاد فبالاجتماع لا ينعدم هذا الاحتمال، بمنزلة اجتماع السودان على شئ لا يعدم صفة السواد الموجود في كل واحد منهم قبل الاجتماع، وهذا لانه كما يتوهم أن يجتمعوا على الصدق فيما ينقلون يتوهم أن يجتمعوا على الكذب، إذ الخبر يحتمل كل واحد من الوصفين على السواء، ألا ترى أن النصارى واليهود
اتفقوا على قتل عيسى عليه السلام وصلبه، ونقلوا ذلك فيما بينهم نقلا متواترا وقد كانوا أكثر منا عددا، ثم كان ذلك كذبا لا أصل له، والمجوس اتفقوا على نقل معجزات زرادشت وقد كانوا أكثر منا عددا، ثم كان ذلك كذبا لا أصل له.
فعرفنا أن احتمال التواطؤ على الكذب لا ينتفي بالنقل المتواتر ومع بقائه لا يثبت علم اليقين، فإنما الثابت به علم طمأنينة بمنزلة من يعلم حياة رجل ثم يمر بداره فيسمع النوح ويرى آثار التهيؤ لغسل الميت ودفنه فيخبرونه أنه قد مات ويعزونه ويعزيهم فيتبدل بهذا الحادث العلم الذي كان (له) حقيقة، ويعلمه ميتا على وجه طمأنينة القلب مع احتمال أن ذلك
كله حيلة منهم وتلبيس لغرض كان لاهله في ذلك، فهذا مثله.
وهذا قول رذل أيضا فإن هذا القائل إنه لا يعلم الرسل عليهم السلام حقيقة ولا يصح إيمانه ما لم يعرف الرسل حقيقة، فهو بمنزلة من يزعم أنه لا يعرف الصانع حقيقة، فعرفنا أنه مفسد لدينه باختيار هذا القول، ثم هو جاحد لما يعلمه كل عاقل ضرورة، فإنا إذا رجعنا إلى موضع المعرفة وهو القلب ووجدنا أن المعرفة بالمتواتر من الاخبار يثبت على الوجه الذي يثبت بالعيان، لانا نعلم أن في الدنيا مكة وبغداد بالخبر على وجه ليس فيه احتمال الشك كما نعلم بلدتنا بالمعاينة، ونعرف الجهة إلى مكة يقينا بالخبر كما نعرف الجهة إلى منازلنا يقينا بالمعاينة، ومن أراد الخروج من هذه البلدة إلى بخارى يأخذ في السير إلى ناحية المغرب، كما أن من أراد أن يخرج إلى كاشغر يأخذ في السير إلى ناحية المشرق ولا يشك في ذلك أحد ولا يخطئه بوجه وإنما عرف ذلك بالخبر فلو لم يكن ذلك موجبا علم اليقين لكان هو مخاطرا بنفسه وماله خصوصا في زمان الخوف فينبغي أن يكون فعله ذلك خطأ، وفي اتفاق الناس كلهم على خلافه ما يدفع زعم هذا الزاعم.
وما استدلوا به من نقل النصارى واليهود قتل المسيح وصلبه فهو وهم، لان النقل المتواتر لم يوجد في ذلك، فإن النصارى إنما نقلوا ذلك عن أربعة نفر كانوا مع المسيح
في بيت، إذ الحواريون كانوا قد اختفوا أو تفرقوا حين هم اليهود بقتلهم، وإنما بقي مع المسيح أربعة نفر يوحنا ويوقنا ومتن ومارقيش، ويتحقق من هذه الاربعة التواطؤ على ما هو كذب لا أصل له، وقد بينا أن حد التواتر ما يستوي طرفاه ووسطه، واليهود إنما نقلوا ذلك عن سبعة نفر كانوا دخلوا البيت الذي كان فيه المسيح، وأولئك يتحقق منهم التواطؤ على الكذب، وقد روي أنهم كانوا لا يعرفون المسيح حقيقة حتى دلهم عليه رجل يقال له يهوذا، وكان يصحبه قبل ذلك فاجتعل منهم ثلاثين درهما، وقال إذا رأيتموني أقبل رجلا فاعلموا أنه صاحبكم، وبمثل هذا لا يحصل ما هو حد التواتر.
فإن قيل: الصلب قد شاهده الجماعة التي لا يتصور منهم التواطؤ على الكذب عادة فيتحقق ما هو حد التواتر في الاخبار بصلبه.
قلنا: لا كذلك، فإن فعل الصلب
إنما تناوشوه عدد قليل من الناس ثم سائر الناس يعتمدون خبرهم أن المصلوب فلان وينظرون إليه من بعد من غير تأمل فيه ففي الطباع نفرة عن التأمل في المصلوب والحلي تتغير به أيضا فيتمكن فيه الاشتباه باعتبار هذه الوجوه، فعرفنا أنه كما لا يتحقق النقل المتواتر في قتله لا يتحقق في صلبه، والثاني أن النقل المتواتر منهم في قتل رجل علموه عيسى وصلبه، وهذا النقل موجب علم اليقين فيما نقلوه ولكن لم يكن الرجل عيسى وإنما كان مشبها به، كما قال تعالى: (ولكن شبه لهم) وقد جاء في الخبر أن عيسى عليه السلام قال لمن كان معه: من يريد منكم أن يلقي الله شبهي عليه فيقتل وله الجنة ؟ فقال رجل: أنا، فألقى الله تعالى شبه عيسى عليه فقتل ورفع عيسى إلى السماء.
فإن قيل: هذا القول في نهاية من الفساد لان فيه قولا بإبطال المعارف أصلا وبتكذيب العيان، وإذا جوزتم هذا فما يؤمنكم من مثله فيما ينقل بالتواتر عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن السامعين إنما سمعوا ذلك من رجل كان عندهم أنه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن إياه وإنما ألقى الله شبهه على غيره، ومع هذا القول لا يتحقق الايمان بالرسل لمن يعانيهم لجواز أن يكون شبه الرسل ملقى على غيرهم، كيف والايمان بالمسيح كان واجبا عليهم في ذلك الوقت فمن ألقي عليه شبه المسيح فقد كان الايمان به واجبا بزعمكم، وفي هذا قول بأن الله تعالى أوجب على عباده الكفر بالحجة فأي قول أقبح من هذا ؟ قلنا.
الامر ليس كما توهمتم فإن إلقاء شبه المسيح على غيره غير مستبعد في القدرة ولا في الحكمة بل فيه حكمة بالغة وهو دفع شر الاعداء عن المسيح فقد كانوا عزموا على قتله وفي هذا دفع عنه مكرو القتل بوجه لطيف، ولله لطائف في دفع الاذى عن الرسل عليهم السلام، والذين قصدوه بالقتل قد علم الله منهم أنهم لا يؤمنون به فألقى شبهه على غيره على سبيل الاستدراج لهم ليزدادوا طغيانا ومرضا إلى مرضهم، ومثل ذلك لا يتوهم في حق قوم يأتون الرسل ليؤمنوا به ويتعظوا بوعظه، فظهر أن الفاسد قول من يقول بأن هذا يؤدي إلى إبطال المعارف والتكذيب بالرسل، ويرد ظاهر قوله تعالى: (ولكن شبه لهم) وبيان أن هذا غير مستبعد
في القدرة غير مشكل فإن إلقاء الشبه دون إيجاد الاصل لا محالة، وقد ظهر إبليس عليه اللعنة مرة في صورة شيخ من أهل نجد ومرة في صورة سراقة بن مالك وكلم المشركين فيما كانوا هموا به في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه نزل قوله تعالى: (وإذ يمكر بك الذين كفروا) الآية، ورأت عائشة رضي الله عنها دحية الكلبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخبرته بذلك قال كان معي جبريل عليه السلام، ورأى ابن عباس رضي الله عنهما جبريل أيضا في صورة دحية الكلبي، ورأته الصحابة حين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي ثائر الرأس يسأله معالم الدين، فعرفنا أن مثل هذا غير مستبعد في زمن الرسل، وأرى الله تعالى المشركين في أعين
المسلمين قليلا يوم بدر مع كثرة عددهم لانه لو أراهم كثرتهم وعدتهم لامتنعوا من قتالهم فأراهم بصفة القلة حتى رغبوا في قتالهم وقتلوهم كما قال تعالى: (ليقضي الله أمرا كان مفعولا) فعرفنا أن مثله غير مستبعد.
فأما نقل المجوس ما نقلوه عن زرادشت فذلك كله تخييلات بمنزلة فعل المشعوذين أو لعب النساء والصبيان إلا ما ينقل أنه أدخل قوائم فرس الملك كشتاسب في بطنه ثم أخرجه وهذا إنما ينقل أنه فعله في مجلس الملك بين يدي خواصه وأولئك يتصور منهم الاجتماع على الكذب فلا يثبت (به) النقل المتواتر، كيف وقد روي أن الملك لما اختبره وعلم خبثه ودهاءه وواطأه على أن يؤمن به ويجعل هو أحد أركان دينه دعاه الناس إلى تعظيم الملوك وتحسين أفعالهم ومراعاة حقوقهم في كل حق وباطل، ويكون هو من ورائه بالسيف يجبر الناس على الدخول في دينه، وحملهم على هذه المواطأة حاجتهم إلى ذلك، فإنه لم يكن لذلك الملك بيت قديم في الملك فكان الناس لا يعظمونه، فاحتالوا بهذه الحيلة، ثم نقلوا عنه أمورا بعد ذلك بين يدي الملك وخاصته، وكل ذلك كذب لا أصل له.
فإن قيل: مثل هذه المواطأة لا تنكتم عادة فكيف انكتم في ذلك الوقت حتى اتفقوا على الايمان به وكذلك من بعدهم إلى زمان طويل وجعلوا ينقلون ذلك نقلا
متواترا ؟ قلنا: إنما لا تنكتم المواطأة التي تكون بين جمع عظيم فأما ما يكون بين الملك وخواصه تنكتم، فإنهم رصد لحفظ الاسرار وإنما يخصهم الملك بهذا الشرط لان تدبير الملك لا يتم مستويا إلا بحفظ الاسرار، وهذا معروف في عادة أهل كل زمان أن المواطأة التي تكون بين الملك وخواصه لا تظهر للعوام، فعرفنا أنه لا يوجد النقل الموجب لعلم اليقين في شئ من هذه الاخبار.
فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فقد كانوا من قبائل مختلفة وكانوا عددا لا يتوهم اجتماعهم
وتواطؤهم على الاختراع عادة لكثرتهم، فعرفنا أن ما نقلوه عنه بمنزلة المسموع منه في كونه موجبا علم اليقين، لانه لما انتفى تهمة احتمال المواطأة تعين جهة السماع.
فإن قيل: مع هذا توهم الاتفاق على الكذب غير منقطع لانه ليس شرط التواتر اجتماع أهل الدنيا وإذا اجتمع أهل بلدة أو عامتهم على شئ يثبت به التواتر، كيف وقد نقل الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم كانوا عسكره لما تحقق منهم الاجتماع على صحبته مع تباين أمكنتهم، فذلك يوهم الاتفاق منهم على نقل ما لا أصل له ؟ قلنا: مثل هذا الاتفاق من الجمع العظيم خلاف العادة وهو نادر غاية وعادة والبناء على ما هو معتاد البشر، ألا ترى أن المعجزات توجب العلم بالنبوة قطعا لكونها خارجة عن حد معتاد البشر، ولو أن واحدا قال في زماننا صعدت السماء وكلمت الملائكة نقطع القول بأنه كاذب لكون ما يخبر به خارجا عما هو المعتاد، والتوهم بعد ذلك غير معتبر، ولهذا قلنا لو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته يوم النحر بمكة وآخران أنه أعتق عبده في ذلك اليوم بعينه بكوفة لا تقبل الشهادة، لان كون الانسان في يوم واحد بمكة وكوفة مستحيل عادة فيسقط ما وراءه من التوهم، يوضحه أنه لو كان هنا توهم الاتفاق على الكذب لظهر ذلك في عصرهم أو بعد ذلك إذا تطاول الزمان، فقد كانوا ثلاثين ألفا أو أكثر والمواطأة فيما بين مثل هذا الجمع العظيم لا ينكتم عادة بل يظهر، كيف وقد اختلط بهم المنافقون وجواسيس الكفرة، كما قال تعالى: (وفيكم سماعون لهم) وقد كان في المسلمين أيضا من يلقي إلى الكفار
بالمودة ويظهر لهم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب وغيره، والانسان يضيق صدره عن سره حتى يفشيه إلى غيره ويستكتمه، ثم السامع يفشيه إلى غيره حتى يصير ظاهرا عن قريب، فلو كان هنا توهم المواطأة لظهر ذلك، فالقول بأنه كان بينهم مواطأة وانكتم أصلا شبه المحال، وهو بمنزلة قول من يزعم أن الكفار عارضوا
القرآن بمثله ثم انكتم ذلك فإن هذا الكلام بالاتفاق بين المسلمين شبه المحال، لان النبي عليه السلام تحداهم في محافلهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو سورة منه فلو قدروا على ذلك لما أعرضوا عنه إلى بذل النفوس والاموال والحرم في غزواته، ولو عارضوه به لما خفي ذلك، فقد كان المشركون يومئذ أكثر من المسلمين، ولو لم يظهر الآن فيما بين المسلمين لظهر في ديار الشرك إذ لا خوف لهم، وتلك المعارضة حجة لهم لو كانت، والانسان على نقل الحجة يكون أحرص منه على نقل الشبهة، كيف وقد نقلت كلام مسليمة ومخاريق المتنبئين من غير أن يكون لشئ من ذلك أصل، فكما تبين بهذا التقرير انقطاع توهم المعارضة، وكون القرآن حجة موجبة للعلم قطعا فكذلك ينقطع هذا التوهم في المتواتر من الاخبار.
فإن قيل: لكونه خلاف العادة أثبتنا علم طمأنينة القلب به ولكون الاتفاق متوهما لم نثبت به علم اليقين كما ذكرنا من حال من رأى آثار الموت في دار إنسان وأخبر بموته.
قلنا: طمأنينة القلب في الاصل إنما تكون بمعرفة حقيقة الشئ، فإن امتنع ثبوت ذلك في موضع فذلك لغفلة من الناظر حيث اكتفى بالظاهر، ولو تأمل وجد في طلب الباطن لظهر عنده التلبيس والفساد، كما يكون في حق المخبر بموت الميت، وإنما تتحقق هذه الغفلة في موضع يكون وراء ما غايته حد آخر، بمنزلة ما يراه النائم في منامه، فإن عنده أن ما يراه هو الحقيقة في ذلك الوقت، ولكن لما كان وراء هذا الحد حد آخر للمعرفة فوقه وهو ما يكون في حالة اليقظة، فباعتبار هذه المقابلة يظهر أن ما يراه في النوم لم يكن موجبا للمعرفة حقيقة، فأما هنا ليس وراء الطمأنينة الثابتة بخبر التواتر حد آخر للعلم فوقه على ما بينا أن الثابت بخبر التواتر والثابت بالمعاينة في وقوع العلم به سواء، فالموجب للعلم هنا معنى في قوة الدليل وهو انقطاع
توهم المواطأة ومثل هذا كلما ازداد المرء التأمل فيه ازداد يقينا، فالتشكيك فيه
يكون دليل نقصان العقل بمنزلة التشكيك في حقائق الاشياء المحسوسة، والطمأنينة التي تكون باعتبار كمال العقل تكون عبارة عن معرفة الشئ حقيقة لا محالة.
وبهذا يتبين فساد قولهم إنه ليس في الجماعة إلا اجتماع الافراد، لان مثل هذه الطمأنينة لا تثبت بخبر الفرد وتوهم الكذب في ذلك الخبر غير خارج عن حد المعتاد.
ثم هذا باطل فإن الواحد منا يمكنه أن يتكلم بحروف الهجاء كلها، وهل لقائل أن يقول لقدرته على ذلك يتوهم منه أن يأتي بمثل القرآن ففيه تلك الحروف بعينها، وكذلك الغبي منا يمكنه أن يتكلم بكل حكمة من شعر امرئ القيس وغيره ثم لا يقول أحد إنه لقدرته على ذلك يقدر على (إنشاء) قصيدة مثل تلك القصيدة، وقد يتكلم الانسان عن ظن وفراسة فيصيب مرة ثم لا يقول أحد إنه يصيب في كل ما يتكلم (به) بهذا الطريق اعتبارا للجملة بالفرد، واتفاق مثل هذا الجمع على الصدق كان بجامع جمعهم عليه وهو دعاء الدين والمروءة على الصدق، وإنما تدعي انقطاع توهم اتفاقهم مع اختلاف الطبائع والاهواء من غير جامع يجمعهم على ذلك، فأما عند وجود الجامع فهو موافق للمعتاد.
فإن قيل: لو تواتر الخبر عند القاضي بأن الذي في يد زيد ملك عمرو لم يقض له بالملك بدون إقامة البينة، ولو ثبت له علم اليقين بذلك لتمكن من القضاء به.
قلنا: هذا أولا يلزم الخصم فإنه يثبت علم طمأنينة القلب بخبر التواتر، وبه يتمكن من القضاء لان بشهادة الشاهدين لا يثبت فوق ذلك.
فأما عندنا فيحتمل أن يقال بأنه يقضي لانه مأمور شرعا بأن يقضي بالعلم ويحتمل أن لا يقضي، بمنزلة ما لو صار معلوما له بمعاينة السبب قبل أن يقلد القضاء فيما ثبت مع الشبهات وفيما يندرئ بالشبهات من الحدود التي هي لله تعالى، وإن صار معلوما له بعدما قلد القضاء لم يقض به ما لم تشهد
الشهود، وعلم اليقين يثبت له بمعاينة السبب لا محالة، ألا ترى أن الشاهد لو قال
أخبر لم يجز للقاضي أن يقضي بقوله، وفيما يرجع إلى العلم لا فرق بين قوله أشهد وبين قوله أخبر، فعرفنا أن في باب القضاء تعتبر الشرائط سوى العلم بالشئ ليتمكن القاضي من القضاء به.
ثم المذهب عند علمائنا أن الثابت بالمتواتر من الاخبار علم ضروري كالثابت بالمعاينة.
وأصحاب الشافعي يقولون: الثابت به علم يقين ولكنه مكتسب لا ضروري بمنزلة ما يثبت من العلم بالنبوة عند معرفة المعجزات، فإنه علم يقين ولكنه مكتسب لا ضروري، وهذا لان فيما يكون ضروريا لا يتحقق الاختلاف فيما بين الناس، وإذا وجدنا الناس مختلفين في ثبوت علم اليقين بالخبر المتواتر عرفنا أنه مكتسب.
ولكنا نقول: هذا فاسد فإنه لو كان طريق هذا العلم الاكتساب لاختص به من يكون من أهل الاكتساب، ورأينا أنه لا يختص هذا العلم بمن يكون من أهل الاكتساب، فكل واحد منا في صغره كان يعلم أباه وأمه بالخبر كما يعلمه بعد البلوغ ولو كان طريقه الاكتساب لتمكن المرء من أن يترك هذا الاكتساب فلا يقع له العلم، وبالاتفاق العلم الذي يحصل بخبر التواتر لا يتمكن المرء من دفعه بكسب يباشره أو بالامتناع من اكتسابه، فعرفنا أنه ثابت ضرورة.
فأما المعجزة فهناك يحتاج إلى (أن) تميز المعجزة من المخرقة، وتمييز ما يكون في حد مقدور البشر مما يكون خارجا من ذلك، ولا طريق إلى هذا التمييز إلا بالاستدلال، فعرفنا أن العلم الثابت به طريقه طريق الاستدلال، وقد بينا أنه لا خلاف بين من لهم عقول كاملة في العلم الواقع بخبر المتواتر وإنما الاختلاف ناشئ من نقصان العقل لبعض الناس وترك التأمل وذلك دليل وسواس يعتري بعض الناس كما يكون في المعلوم بالحواس، وبالاتفاق لا يعتبر هذا الاختلاف في المعلوم بالحواس ويكون العلم الواقع به ضروريا، فكذلك في المعلوم بخبر التواتر.
ثم اختلف مشايخنا فيما هو متواتر الفرع آحاد الاصل من الاخبار وهو الذي تسميه الفقهاء في حيز التواتر والمشهور من الاخبار، فكان أبو بكر
الرازي رحمه الله يقول هذا أحد قسمي المتواتر على معنى أنه يثبت به علم اليقين ولكنه علم اكتساب كما قال أصحاب الشافعي في القسم الآخر، وكان عيسى بن أبان رحمه الله يقول لا يكون المتواتر إلا ما يوجب العلم ضروريا، فأما النوع الثاني فهو مشهور وليس بمتواتر وهو الصحيح عندنا.
وبيان هذا النوع في كل حديث نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد يتوهم اجتماعهم على الكذب ولكن تلقته العلماء بالقبول والعمل به، فباعتبار الاصل هو من الآحاد، وباعتبار الفرع هو متواتر، وذلك نحو خبر المسح على الخفين، وخبر تحريم المتعة بعد الاباحة، وخبر تحريم نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها، وخبر حرمة التفاضل في الاشياء الستة وما أشبه ذلك.
أما أبو بكر الرازي كان يقول لما تواتر نقل هذا الخبر إلينا من قوم لا يتوهم اجتماعهم على الكذب فقد أوجب لنا ذلك علم اليقين وانقطع به توهم الاتفاق في الصدر الاول، لان الذين تلقوه بالقبول والعمل به لا يتوهم اتفاقهم على القبول إلا بجامع جمعهم على ذلك وليس ذلك إلا تعين جانب الصدق في الذين كانوا أهلا من رواته، ولكن إنما عرفنا هذا بالاستدلال فلهذا سمينا العلم الثابت به مكتسبا وإن كان مقطوعا به، بمنزلة العلم بمعرفة الصانع، ألا ترى أن النسخ يثبت بمثل هذه الاخبار، فإنه يثبت بها الزيادة على كتاب الله تعالى والزيادة على النص نسخ ولا يثبت نسخ ما يوجب علم اليقين إلا بمثل ما يوجب علم اليقين.
وجه قول عيسى أن ما يكون موجبا علم اليقين فإنه يكفر جاحده كما في المتواتر الذي يوجب العلم ضرورة، وبالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور من الاخبار، فعرفنا أن الثابت به علم طمأنينة القلب لا علم اليقين وهذا لانه وإن تواتر نقله من الفريق الثاني والثالث فقد بقي فيه شبهة توهم الكذب عادة باعتبار الاصل، فإن رواته عدد يسير وعلم اليقين إنما يثبت إذا اتصل بمن هو معصوم عن الكذب، على وجه لا يبقى فيه شبهة الانفصال، وقد بقي هنا شبهة الانفصال باعتبار الاصل فيمنع
ثبوت علم اليقين به، يقرره أن العلم الواقع لنا بمثل هذا النقل إنما يكون قبل التأمل في شبهة الانفصال، فأما عند التأمل في هذه الشبهة يتمكن نقصان فيه، فعرفنا أنه علم طمأنينة، فأما العلم الواقع بما هو متواتر بأصله وفرعه فهو يزداد قوة بالتأمل فيه،
ثم قد بينا أن التفاوت يظهر عند المقابلة فإذا لم يكن وراء القسم الاول حد آخر عرفنا أن الثابت به علم ضرورة، ولما كان وراء القسم الثاني حد آخر عرفنا أن الثابت به علم طمأنينة.
ولكن مع هذا تجوز الزيادة على النص بهذا النوع من الاخبار، لان العلماء لما تلقته بالقبول والعمل به كان دليلا موجبا فإن الاجماع من العصر الثاني والثالث دليل موجب شرعا، فلهذا جوزنا به الزيادة على النص، ولكن مع هذا بقي فيه شبهة توهم الانفصال فلا يكفر جاحده، وما هذا إلا نظير ما تقدم بيانه، فإن العلم بكون المسيح عليه السلام مبعوثا إلى بني إسرائيل ثابت بالنقل المتواتر أصلا وفرعا على وجه لم يبق فيه توهم الشبهة لاحد، ثم بنقلهم المتواتر أنه قتل أو صلب لا يثبت العلم، لان ذلك آحاد الاصل متواتر الفرع كما قررنا.
فإن قيل: (فكان ينبغي) أن يثبت به طمأنينة القلب كما أثبتم هنا.
قلنا: إنما لم نثبت لانه اعترض ما هو أقوى منه فيما يرجع إلى العلم وهو إخبار علام الغيوب بأنهم ما قتلوه يقينا، والحجج التي تثبت بها طمأنينة القلب إذا اعترض عليها ما هو أقوى لم يبق علم طمأنينة القلب بها.
ثم ذكر عيسى رحمه الله أن هذا النوع من الاخبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يضلل جاحده ولا يكفر وذلك نحو خبر الرجم، وقسم لا يضلل جاحده ولكن يخطأ ويخشى عليه المأثم وذلك نحو خبر المسح بالخف وخبر حرمة التفاضل، وقسم لا يخشى على جاحده المأثم ولكن يخطأ في ذلك وهو الاخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الاحكام.
وهذا الذي قاله صحيح بناؤه على تلقي العلماء إياه بالقبول ثم العمل
بموجبه فإن خبر الرجم اتفق عليه العلماء من الصدر الاول والثاني، وإنما خالف فيه الخوارج وخلافهم لا يكون قدحا في الاجماع، ولهذا قال يضلل جاحده.
فأما خبر المسح ففيه شبهة الاختلاف في الصدر الاول، فإن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم كانا يقولان سلوا هؤلاء الذين يرون المسح هل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سورة المائدة ؟ والله ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سورة المائدة، وقد
نقل رجوعهما عن ذلك أيضا وكذلك خبر الصرف فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجوز التفاضل مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم : لا ربا إلا في النسيئة وقد نقل رجوعه عن ذلك، فلشبهة الاختلاف في الصدر الاول قلنا بأنه لا يضلل جاحده ولكن يخشى عليه المأثم، ولان باعتبار رجوعهم يثبت الاجماع (وقد ثبت الاجماع) على قبوله من الصدر الثاني والثالث ولا يسع مخالفة الاجماع، فلهذا يخشى على جاحده المأثم.
وأما النوع الثالث فقد ظهر فيه الاختلاف في كل قرن فكل من ترجح عنده جانب الصدق فيه بدليل عمل به وكان له أن يخطئ صاحبه ولكن لا يخشى عليه المأثم في ذلك لانه صار إليه عن اجتهاد، والاثم في الخطأ موضوع عن المجتهد على ما نبينه إن شاء الله تعالى.
وأما الغريب المستنكر فإنه يخشى المأثم على العامل به، وذلك نحو خبر القتل في القسامة وخبر القضاء بالشاهد واليمين، لانه مخالف لظاهر القرآن وقد ترك العلماء في القرن الاول والثاني العمل به فبه يقرب من الكذب، كما أن المشهور يقرب من الصدق بتلقيهم إياه بالقبول والعمل به، فكما يخشى المأثم هناك على ترك العمل به لقربه من الصدق فكذلك يخشى على من يعمل بالغريب المستنكر لقربه من الكذب، والثابت بمثله مجرد الظن ومن الظن ما يأثم المرء باتباعه، قال تعالى: (وظننتم ظن السوء) وقال تعالى: (إن بعض الظن إثم) وهو نظير من يصير إلى
التحري عند اشتباه القبلة فيعمل به مع وجود الدليل ويترك العمل بالدليل، ولا شك في تأثيم من يدع العمل بالدليل ويعمل بالظن، فهذا مثله، والله أعلم.
ذكر عيسى رحمه الله أنه ليس لما ينعقد به التواتر حد معلوم من حيث العدد، وهو الصحيح، لان خبر التواتر يثبت علم اليقين ولا يوجد حد من حيث العدد يثبت به علم اليقين وإذا انتقص منه بفرد لا يثبت علم اليقين.
ولكنا نعلم أن بالعدد اليسير لا يثبت ذلك لتوهم المواطأة بينهم وبالجمع العظيم يثبت ذلك لانعدام توهم
المواطأة، فإنما يبني على هذا أنه متى كان المخبرون بحيث يؤمن تواطؤهم عادة يكون خبرهم متواترا.
والحدود نوعان: منه ما يكون متميز الاطراف والوسط كالمقادير في الحدود الشرعية، ومنه ما يكون متميز الاطراف مشكل الوسط كالسير بالاميال والاكل بالارطال.
فهذا مما هو متميز الاطراف مشكل الوسط، والطريق فيه ما بينا.
فصل: في بيان أن إجماع هذه الامة موجب للعلم قال رضي الله عنه: اعلم أن إجماع هذه الامة موجب للعلم قطعا كرامة لهم على الدين لا لانقطاع توهم اجتماعهم على الضلال بمعنى معقول، فاليهود والنصارى والمجوس أكثر منا عددا وقد وجد منهم الاجماع على الضلالة، ولان الاتفاق قد يتحقق من الخلف على وجه المتابعة للآباء من غير حجة كما أخبر الله تعالى عن الكفرة بقوله تعالى: (إنا وجدنا آباءنا على أمة) وقال تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) فعرفنا أنه إنما جعل اجتماع هذه الامة حجة شرعا كرامة لهم على الدين.
فهذا مذهب الفقهاء وأكثر المتكلمين.
وقال النظام وقوم من الامامية لا يكون الاجماع حجة موجبة للعلم بحال لانه ليس فيه إلا اجتماع الافراد وإذا كان قول كل فرد غير موجب للعلم لكونه غير معصوم عن الخطأ فكذلك أقاويلهم بعدما
اجتمعوا لان توهم الخطأ لا ينعدم بالاجتماع، ألا ترى أن كل واحد منهم لما كان إنسانا قبل الاجتماع فبعد الاجتماع هم ناس وكل واحد من القادرين حالة الانفراد لا يصير عاجزا بعد الاجتماع، وكل واحد من العميان عند الانفراد لا يصير بصيرا بالاجتماع، ولا تصير جملتهم أيضا بهذه الصفة بعد الاجتماع.
وهذا الكلام ظاهر التناقض والفساد فقد ثبت بالاجتماع ما لا يكون ثابتا عند الانفراد في المحسوسات والمشروعات، فإن الافراد لا يقدرون على حمل خشبة ثقيلة وإذا اجتمعوا قدروا على ذلك، واللقمة الواحدة من الطعام والقطرة من الماء لا تكون مشبعة ولا مروية ثم عند الاجتماع تصير مشبعة ومروية، وهذا لان بالاجتماع يحدث ما لم يكن عند الانفراد وهو الدليل الجامع لهم على
ما اتفقوا عليه، وقد قررنا هذا في الخبر المتواتر، ومن أنكر كون الاجماع حجة موجبة للعلم فقد أبطل أصل الدين فإن مدار أصول الدين ومرجع المسلمين إلى إجماعهم فالمنكر لذلك يسعى في هدم أصل الدين.
وسنقرر هذا في آخر الفصل.
ثم الدليل على أن الاجماع من هذه الامة حجة موجبة شرعا، وأنهم إذا اجتمعوا على شئ فالحق فيما اجتمعوا عليه قطعا، وإذا اختلفوا في شئ فالحق لا يعدوهم أصلا الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) وكلمة خير بمعنى أفعل فيدل على النهاية في الخيرية وذلك دليل ظاهر على أن النهاية في الخيرية فيما يجتمعون عليه، ثم فسر ذلك بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإنما جعلهم خير أمة بهذا، والمعروف المطلق ما هو حق عند الله تعالى، فأما ما يؤدي إليه اجتهاد المجتهدين فإنه غير معروف مطلقا، إذ المجتهد يخطئ ويصيب ولكنه معروف في حقه على معنى أنه يلزمه العمل به ما لم يتبين خطؤه، ففي هذا بيان أن المعروف المطلق ما يجتمعون عليه.
فإن قيل: هذا يقتضي كون كل واحد منهم آمرا بالمعروف كما ذكرنا في موجب
الجمع المضاف إلى جماعة وبالاجماع اجتهاد كل واحد منهم بانفراده لا يكون موجبا للعلم قطعا.
قلنا: لا بل المراد هنا أن جميع الامة أو أكثرهم بهذه الصفة، ونظيره قوله تعالى: (وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك) .
(وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها) وكان ذلك من بعضهم.
ويقال في بذلة الكلام: بنو هاشم حكماء، وأهل الكوفة فقهاء، وإنما يراد بعضهم، فيتبين بهذا التحقيق أن المراد بيان أن الاكثر من هذه الامة إذا اجتمعوا على شئ فهو المعروف مطلقا، وأنهم إذا اختلفوا في شئ فالمعروف المطلق لا يعدو أقوالهم، وقال تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين) الآية، فقد جعل الله اتباع غير سبيل المؤمنين بمنزلة مشاقة الرسول في استيجاب النار.
ثم قول الرسول موجب للعلم قطعا فكذلك ما اجتمع عليه المؤمنون، ولا يجوز أن يقال المراد اجتماع الخصلتين لان في ذكرهما دليلا على أن تأثير أحدهما كتأثير الآخر، بمنزلة قوله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله
إلها آخر) إلى قوله: (ومن يفعل ذلك يلق أثاما) وأيد هذا قوله تعالى: (ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة) ففي هذا تنصيص على أن من اتخذ وليجة من دون المؤمنين فهو بمنزلة من اتخذ وليجة من دون الرسول.
وقال تعالى: (وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم) وفيه تنصيص على أن المرضي عند الله ما هم عليه حقيقة، ومعلوم أن الارتضاء مطلقا لا يكون بالخطأ وإن كان المخطئ معذورا وإنما يكون بما هو الصواب، فعرفنا أن الحق مطلقا فيما اجتمعوا عليه.
وقال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) والوسط العدل المرضي قال تعالى: (أوسطهم) أي أعدلهم وأرضاهم قولا، وقال القائل: هم وسط يرضى الانام بحكمهم أي عدل، ففي الوصف لهم بالعدالة تنصيص على أن الحق ما يجتمعون عليه،
ثم جعلهم شهداء على الناس والشاهد مطلقا من يكون قوله حجة، ففي هذا بيان أن إجماعهم حجة على الناس وأنه موجب للعلم قطعا، ولا معنى لقول من يقول الشهود في الحقوق عند القاضي وإن جعلت شهادتهم حجة فإنها لا تكون موجبة للعلم قطعا، وهذا لان شهادتهم حجة في حق القاضي باعتبار أنه مأمور بالقضاء بالظاهر فإن ما وراءه غيب عنه ولا طريق له إلى معرفته فيكون حجة بحسب ذلك، وأما هنا فقد جعل الله تعالى هذه الامة شهداء على الناس بما هو حق الله تعالى (على الناس وهو علام الغيوب لا تخفى عليه خافية فإن ما يكون حجة لحق الله تعالى) على الناس ما يكون موصوفا بأنه حق قطعا، كيف وقد جعل الله شهادتهم على الناس كشهادة الرسول عليهم، فقال تعالى: (ويكون الرسول عليكم شهيدا) وشهادة الرسول حجة موجبة للعلم قطعا لانه معصوم عن القول بالباطل، فتبين بهذه المقابلة أن شهادة الامة في حق الناس بهذه الصفة، ولا يجوز أن يقال هذا في حكم الآخرة لانه لا تفصيل في الآية، ولان ما في الآخرة يكون أداء الشهادة في مجلس القضاء والقاضي علام الغيوب عالم بحقائق الامور فما لم يكونوا عالمين بما هو الحق في الدنيا لا يصلحون للاداء بهذه الصفة في الآخرة مع أن الشهادة في الآخرة مذكورة
في الآيتين من كتاب الله تعالى في قوله تعالى: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) وفي قوله تعالى: (ويوم نبعث من كل أمة شهيدا) الآية، فتبين أن المراد بما تلونا الشهادة بحقوق الله تعالى على الناس في الدنيا.
ولا يقال كما وصف الله هذه الامة بأنهم شهداء فقد وصف به أهل الكتاب، قال تعالى: (يأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء) وقال تعالى: (بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) ثم لم يدل ذلك على أن إجماعهم موجب للعلم وهذا لان الله تعالى إنما جعلهم شهداء
بما أخذ الميثاق به عليهم وهو بيان نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابهم للناس، كما قال تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه) الآية، ولو بينوا كان بيانهم حجة، إلا أنهم لما تعنتوا واشتغلوا بالحسد وطلب الرياسة كفروا بذلك، وإنما سماهم أهل الكتاب باعتبار ما كانوا عليه من قبل ولذلك جعلهم شهداء على حفظ الكتاب، فما لم يبدلوا كان قولهم حجة، ولكنهم حرفوا وغيروا ذلك فلهذا لا يكون قولهم حجة، فأما هنا فقد جعل الله هذه الامة شهداء على الناس، فعرفنا أن قولهم حجة في إلزام حقوق الله على الناس إلى قيام الساعة.
ولا يقال فقد ثبت حق الله بما لا يوجب العلم قطعا نحو خبر الواحد والقياس وهذا لان خبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله حجة موجبة للعلم قطعا، ولكن امتنع ثبوت العلم به لشبهة في النقل، واحتمل ذلك لضرورة فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقياس لا يكون حجة لاثبات الحكم ابتداء بل بتعدية الحكم الثابت بالنص إلى محل لا نص فيه، واحتمل ذلك لضرورة حاجتنا إلى ذلك، فأما هنا فقد جعل الله تعالى الامة شهداء على الناس مطلقا، وذلك لا يكون إلا إذا كان الحق مطلقا فيما يشهدون به.
فإن قيل: وصف الله تعالى إياهم بهذا لا يكون دليلا على أنه لا يتوهم اجتماعهم على ما هو ضلالة، كما في قوله تعالى: (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) ففيه بيان أنه خلقهم للعبادة ثم لا يمنع ذلك توهم اجتماعهم على ترك العبادة.
قلنا: اللام
المذكور في قوله تعالى: (ليكونوا) يدل على أنه جعلهم بهذه الصفة كرامة لهم ليكون قولهم حجة على الناس في حق الله، كما يقول إنه جعل الناس أحرارا ليكونوا أهلا للملك فإنما يفهم منه أن الاهلية للملك ثابت لهم باعتبار الحرية، فهاهنا أيضا يفهم من الآية أن قولهم حجة على الناس باعتبار صفة الوساطة لهم، وهكذا
كان يقتضي ظاهر قوله تعالى: (إلا ليعبدون) غير أنا لو حملنا على هذا الظاهر خرجت العبادة من أن ينالها ثواب أو عقاب بتركها، لان ذلك يثبت باختيار يكون من العبد عند الاقدام عليه، فعرفنا أن المراد من قوله: (إلا ليعبدون) إلا وعليهم العبادة لي.
وبأن بترك الظاهر في موضع لقيام الدليل لا يمنع العمل بالظاهر فيما سواه، وتبين أن ما نحن فيه نظير شهادة الرسول علينا كما ذكره الله معطوفا على هذه الصفة لا نظير ما استشهدوا به.
وأما السنة فقد جاءت مستفيضة مشهورة في ذلك: فمنها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومنها حديث معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة ولاة الامر، ولزوم جماعة المسلمين ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في النار وقال عليه السلام: من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وقال عليه السلام: إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة ولما سئل عن الخميرة التي يتعاطاها الناس قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح والآثار في هذا الباب كثيرة تبلغ حد التواتر، لان كل واحد منهم إذا روي حديثا في هذا الباب سمعه في جمع ولم ينكر عليه أحد من ذلك الجمع فذلك بمنزلة المتواتر، كالانسان إذا رأى القافلة بعد انصرافها من مكة وسمع من كل فريق واحدا يقول: قد حججنا، فإنه يثبت له علم اليقين بأنهم حجوا في تلك السنة.
وشئ من المعقول يشهد به، فإن الله تعالى جعل الرسول خاتم النبيين وحكم
ببقاء شريعته إلى يوم القيامة وأنه لا نبي بعده، وإلى ذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناوأهم فلا بد من أن تكون شريعته ظاهرة في الناس إلى قيام الساعة وقد انقطع الوحي بوفاته، فعرفنا ضرورة أن طريق بقاء شريعته عصمة الله أمته من أن يجتمعوا على الضلالة فإن في الاجتماع على الضلالة رفع الشريعة وذلك يضاد الموعود من البقاء، وإذا ثبت عصمة جميع الامة من الاجتماع على الضلالة ضاهى ما أجمعوا عليه المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك موجب للعلم قطعا، فهذا مثله.
وهذا معنى ما قلنا إن عند الاجتماع يحدث ما لم يكن ثابتا بالافراد، وهو نظير القاضي إذا نفذ قضاء باجتهاد فإنه يلزم ذلك على وجه لا يحتمل النقض، وإن كان ذلك فوق الاجتهاد وكان ذلك لصيانة القضاء الذي هو من أسباب الدين فلان يثبت هنا ما ادعينا صيانة لاصل الدين كان أولى.
فإن قيل: كيف يستقيم هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس وقال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله ؟ قلنا: في صحة هذا الحديث نظر هو في الظاهر مخالف لكتاب الله (الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) ومن كان الله وليه فهو ظاهر أبدا، ومعنى قوله يخرجهم من الظلمات إلى النور: أي من ظلمات الكفر والباطل إلى نور الايمان والحق، فذلك دليل على أن الحق ما يتفقون عليه في كل وقت، وقال تعالى: (هو الذي يصلي عليكم وملائكته) الآية، ولو ثبت الحديث فالمراد بيان أن أهل الشر يغلبون في آخر الزمان مع بقاء الصالحين المتمسكين بالحق فيهم، والمراد بالحديث الآخر بيان الحال بين نفخة الفزع ونفخة البعث، فإن قيام الساعة عند نفخة البعث، وعند ذلك لم يبق في الارض من بني آدم أحد حيا.
ثم الكلام بعد هذا في سبب الاجماع، وركنه، وأهلية من ينعقد به الاجماع،
وشرطه، وحكمه.
فصل: السبب قال رضي الله عنه: اعلم بأن سبب الاجماع قد يكون توقيفا من الكتاب والسنة.
أما الكتاب فنحو الاجماع على حرمة الامهات والبنات، سببه قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) وأما من حيث السنة فنحو الاجماع على أن في اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية، والاجماع على أنه لا يجوز بيع الطعام المشتري قبل القبض، وما أشبه ذلك، فإن سببه السنة المروية في الباب.
ومن ذلك ما يكون مستنبطا بالاجتهاد على ما هو المنصوص عليه من الكتاب أو السنة، وذلك نحو إجماعهم على توظيف الخراج على أهل السواد، فإن عمر رضي الله عنه حين أراد ذلك خالفه بلال مع جماعة من أصحابه حتى تلا عليهم قوله تعالى: (والذين جاؤوا من بعدهم) قال: أرى لمن بعدكم في هذا الفئ نصيبا فلو قسمتها بينكم لم يبق لمن بعدكم فيها نصيب.
فأجمعوا على قوله، وسبب إجماعهم هذا الاستنباط.
ولما اختلفوا في الخليفة بعد رسول الله عليه السلام قال عمر: إن رسول الله اختار أبا بكر لامر دينكم فيكون أرضني به لامر دنياكم.
فأجمعوا على خلافته، وسبب إجماعهم هذا الاستنباط.
ومنها ما يكون عن رأي نحو إجماعهم على أجل العنين، وإجماعهم على الحد على شارب الخمر على ما روي أن عمر رضي الله عنه لما شاورهم في ذلك قال علي: إنه إذا شرب هذي وإذا هذي افترى وحد المفترين في كتاب الله ثمانون جلدة.
وهكذا قاله ابن عوف.
وكان علي يقول: ما من أحد أقيم عليه حدا فيموت فأجد من ذلك في نفسي شيئا إلا حد الخمر فإنه ثبت بآرائنا.
فإن قيل كيف يستقيم هذا وإثبات الحد بالرأي لا يكون ؟ قلنا: لا نقول إثبات أصل الحد كان بالرأي بل بالسنة وهو ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب بالجريد والنعال في شرب الخمر إلا أنهم بالتفحص عرفوا مقدار ما ضرب فيه
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أربعون نفرا وضرب كل واحد بنعليه، فنقلوا بالرأي من النعال إلى الجلدات استدلالا بحد القذف وأثبتوا المقدار بالنص، فأجمعوا أن حد الخمر ثمانون جلدة.
وكان ابن جرير رحمه الله يقول: الاجماع الموجب للعلم قطعا لا يصدر عن خبر الواحد ولا عن قياس، لان خبر الواحد والقياس لا يوجب العلم قطعا فما يصدر عنه كيف يكون موجبا لذلك ؟ ولان الناس يختلفون في القياس هل هو حجة أم لا ؟ فكيف يصدر الاجماع عن نفس الخلاف ؟ وهذا غلط بين، فقد بينا أن إجماع هذه الامة حجة شرعا باعتبار عينه لا باعتبار دليله، فمن يقول بأنه لا يكون إلا صادرا عن دليل موجب للعلم فإنه يجعل الاجماع لغوا وإنما يثبت العلم بذلك الدليل، فهو ومن ينكر كون الاجماع حجة أصلا سواء، وخبر الواحد والقياس وإن لم يكن موجبا للعلم بنفسه فإذا تأيد بالاجماع فذلك يضاهي ما لو تأيد بآية من كتاب الله أو بالعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقرير منه على ذلك فيصير موجبا للعلم من هذا الطريق قطعا، وقد كان في الصدر الاول اتفاق على استعمال القياس وكونه حجة على ما نبينه، وإنما أظهر الخلاف بعض أهل الكلام ممن لا نظر له في الفقه، وبعض المتأخرين ممن لا علم له بحقيقة الاحكام وأولئك لا يعتد بخلافهم ولا يؤنس بوفاقهم.
ثم الاجماع الثابت بهذه الاسباب يثبت انتقاله إلينا بالطريق الذي يثبت به انتقال السنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك (تارة) يكون بالتواتر، وتارة بالاشتهار، وتارة بالآحاد، وذلك نحو ما يروى عن عبيدة السلماني قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شئ كاجتماعهم على المحافظة على الاربع قبل الظهر، وعلى الاسفار بالفجر، وعلى تحريم نكاح الاخت في عدة الاخت.
وقال ابن مسعود
رضي الله عنه في تكبيرات الجنازة: كل ذلك قد كان، وقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون عليها أربعا.
ومن الناس من أنكر ثبوت الاجماع بخبر الواحد لان الاجماع يوجب العلم قطعا وخبر الواحد لا يوجب ذلك، وهذا خطأ بين، فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم موجب للعلم أيضا ثم يجوز أن يثبت ذلك بالنقل
بطريق الآحاد على أن يكون موجبا للعمل دون العلم، فكذلك الاجماع يجوز أن يثبت بالنقل بطريق الآحاد على أن يكون موجبا العمل.
وسنقرر هذا في بيان الحكم إن شاء الله تعالى.
فصل: الركن ركن الاجماع نوعان: العزيمة، والرخصة.
فالعزيمة هو اتفاق الكل على الحكم بقول سمع منهم، أو مباشرة الفعل فيما يكون من بابه على وجه يكون ذلك موجودا من العام والخاص فيما يستوي الكل في الحاجة إلى معرفته لعموم البلوى فيه كتحريم الزنا والربا، وتحريم الامهات وأشباه ذلك، ويشترك فيه جميع علماء العصر، وفيما لا يحتاج العام إلى معرفته لعدم البلوى العام بهم فيه كحرمة المرأة على عمتها وخالتها، وفرائض الصدقات وما يجب في الزروع والثمار وما أشبه ذلك، وهذا لان ركن الشئ ما يقوم به أصله فإنما يقوم أصل الاجماع في النوعين بهذا.
وأما الرخصة وهو أن ينتشر القول من بعض علماء أهل العصر ويسكت الباقون عن إظهار الخلاف وعن الرد على القائلين بعد عرض الفتوى عليهم أو صيرورته معلوما لهم بالانتشار والظهور، فالاجماع يثبت به عندنا.
ومن العلماء من يقول بهذا الطريق لا يثبت الاجماع.
ويحكى عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: إن ظهر القول من أكثر العلماء والساكتون نفر يسير منهم يثبت به الاجماع، وإن انتشر القول من واحد أو اثنين والساكتون أكثر علماء العصر لا يثبت به الاجماع.
وجه قولهم إن السكوت محتمل قد يكون للموافقة وقد يكون للمهابة والتقية مع إضمار الخلاف والمحتمل لا يكون حجة خصوصا فيما يوجب العلم قطعا، ألا ترى أن فيما هو مختلف فيه السكوت لا يكون دليلا على شئ لكونه محتملا.
ويستدلون على صحة هذه القاعدة بما روي أن عمر رضي الله عنه لما شاور الصحابة في مال فضل
عنده للمسلمين فأشاروا عليه بتأخير القسمة والامساك إلى وقت الحاجة وعلي رضي الله عنه في القوم ساكت فقال له: ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال: لم تجعل يقينك شكا وعلمك جهلا ؟ أرى أن تقسم ذلك بين المسلمين وروى فيه حديثا، فهو لم يجعل سكوته دليل الموافقة لهم حتى سأله، واستخار علي رضي الله عنه السكوت مع كون الحق عنده في خلافهم.
ولما شاور عمر الصحابة في إملاص المغيبة التي بعث بها ففزعت فقالوا: إنما أنت مؤدب وما أردت إلا الخير فلا شئ عليك وعلي رضي الله عنه في القوم ساكت فقال: ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال: إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطؤوا، وإن قاربوك فقد غشوك، أرى عليك الغرة.
فقال: أنت صدقتني.
فقد استخار السكوت مع إضمار الخلاف، ولم يجعل عمر سكوته دليل الموافقة حتى استنطقه.
ولما بين ابن عباس حجته في مسألة العول للصحابة قالوا له: هلا قلت هذا لعمر ؟ فقال: كان رجلا مهيبا فهبته، وفي رواية منعني درته من ذلك.
وكان عيسى بن أبان يقول: ترك النكير لا يكون دليل الموافقة بدليل حديث ذي اليدين فإنه حين قال: أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله ؟ فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر وقال: أحق ما يقول ذو اليدين ؟ ولو كان
ترك النكير دليل الموافقة لاكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ولما استنطقهم في الصلاة من غير حاجة.
وكان الكرخي رحمه الله يقول: السكوت على النكير فيما يكون مجتهدا فيه لا يكون دليل الموافقة لانه ليس لاحد المجتهدين أن ينكر
على صاحبه باجتهاده، وليس عليه أن يبين له ما أدى إليه اجتهاده فالسكوت في مثله لا يكون دليل الموافقة.
وجه قولنا إنه لو شرط لانعقاد الاجماع التنصيص من كل واحد منهم على قوله وإظهار الموافقة مع الآخرين قولا أدى إلى أن لا ينعقد الاجماع أبدا، لانه لا يتصور اجتماع أهل العصر كلهم على قول يسمع ذلك منهم إلا نادرا، وفي العادة إنما يكون ذلك بانتشار الفتوى من البعض وسكوت الباقين، وفي اتفاقنا على كون الاجماع حجة وطريقا لمعرفة الحكم دليل على بطلان قول هذا القائل، وهذا لان المتعذر كالممتنع، ثم تعليق الشئ بشرط هو ممتنع يكون نفيا لا صلة فكذا تعليقه بشرط هو متعذر، وهذا لان الله تعالى رفع عنا الحرج كما لم يكلفنا ما ليس في وسعنا، وليس في وسع علماء العصر السماع من الذين كانوا قبلهم يقرون فكان ذلك ساقطا عنهم فكذلك يتعذر السماع من جميع علماء العصر، والوقوف على قول كل واحد منهم في حكم حادثة حقيقة لما فيه من الحرج البين، فينبغي أن يجعل اشتهار الفتوى من البعض والسكوت من الباقين كافيا في انعقاد الاجماع، لان السامعين من العلماء المجتهدين لا يحل لهم السكوت عن إظهار الخلاف إذا كان الحكم عندهم خلاف ما ظهر وسكوتهم محمول على الوجه الذي يحل، فبهذا الطريق ينقطع معنى التساوي في الاحتمال ويترجح جانب إظهار الموافقة، ومثل هذا السكوت لا يرجح أحد الجانبين فيما يكون مختلفا فيه فيبقى محتملا على ظاهره، ولهذا قال الشافعي رحمه الله: إنما يثبت الاجماع إذا اشتهر القول من أكثرهم لان هذا القدر مما يتأتى وإقامة السكوت مقام إظهار الموافقة لدفع الحرج فيتقدر بقدره، ولا حرج في اعتبار ظهور القول من الاكثر، ولان الاقل يجعل تبعا للاكثر، فإذا كان الاكثر سكوتا يجعل ذلك كسكوت الكل، وإذا ظهر القول من الاكثر يجعل كظهوره من الكل.
ولكنا نقول: المعنى الذي لاجله
جعل سكوت الاقل بمنزلة إظهار الموافقة أنه لا يحل لهم ترك إظهار الخلاف إذا كان الحكم عندهم خلاف ذلك، وهذا المعنى فيما يشتهر من واحد أو اثنين أظهر، لان تمكن الاكثر من إظهار الخلاف يكون أبين فلان يجعل سكوتهم عن إظهار الخلاف بعد ما اشتهر القول دليل الموافقة كان أولى.
وأما حديث القسمة فإنما سكت علي رضي الله عنه لان ما أشاروا به على عمر كان حسنا، فإن للامام أن يؤخر القسمة فيما يفضل عنده من المال ليكون معدا لنائبة تنوب المسلمين، ولكن كان القسمة أحسن عند علي لانه أقرب إلى أداء الامانة والخروج عما يحمل من العهدة، وفي مثل هذا الموضع لا يجب إظهار الخلاف ولكن إذا سئل يجب بيان الاحسن، فلهذا سكت علي في الابتداء وحين سأله بين الوجه الاحسن عنده.
وكذا حديث الاملاص فإن ما أشاروا به من الحكم كان صوابا، لانه لم يوجد من عمر رضي الله عنه مباشرة صنع بها ولا تسبب هو جناية، ولكن إلزام الغرة مع هذا يكون أبعد من القيل والقال، ويكون أقرب إلى بسط العدل وحسن الرعاية فلهذا سكت في الابتداء ولما استنطقه بين أولى الوجهين عنده، يوضحه أن مجرد السكوت عن إظهار الخلاف لا يكون دليل الموافقة عندنا ما بقي مجلس المشاورة ولم يفصل الحكم بعد، فإنما يكون هذا حجة أن لو فصل عمر الحكم بقولهم أو ظهر منه توقف في الجواب ويكون علي رضي الله عنه ساكتا بعد ذلك ولم ينقل هذا، فإنما يحمل سكوته في الابتداء على أنه لتجربة أفهامهم، أو لتعظيم الفتوى الذي يريد إظهاره باجتهاده حتى لا يزدري به أحد من السامعين، أو ليروي النظر في الحادثة ويميزه من الاشباه حتى يتبين له ما هو الصواب فيظهره، والظاهر أنه لو لم يستنطقه عمر رضي الله عنه لكان هو بين ما يستقر عليه رأيه من الجواب قبل إبرام الحكم وانقضاء مجلس المشاورة.
فأما حديث ابن عباس فقد قيل إنه لا يكاد يصح لان عمر رضي الله عنه كان يقدم ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يدعوه في مجلس الشورى مع الكبار من
الصحابة لما عرف من فطنته وحسن ذهنه وبصيرته، وقد أشار عليه بأشياء فقبل ذلك واستحسنه، وكان يقول له: غص يا غواص، شنشنة أعرفها من أخزم يعني أنه شبه العباس في رأيه ودهائه، فكيف يستقيم مع هذا أن يقال إنه امتنع من بيان قوله وحجته لعمر مهابة له ؟ وإن صح فهذه المهابة إنما كان باعتبار ما عرف من فضل رأي عمر وفقهه فمنعه ذلك من الاستقصاء في المحاجة معه كما يكون من حال الشبان مع ذوي الاسنان من المجتهدين في كل عصر، فإنهم يهابون الكبار فلا يستقصون في المحاجة معهم حسب ما يفعلون مع الاقران، ومتى كان (الناس) في تقية من عمر في إظهار الحق مع قوله عليه الصلاة والسلام: أينما دار الحق فعمر معه وكان ألين وأسرع قبولا للحق من غيره حتى كان يشاورهم ويقول لهم: لا خير فيكم إذا لم تقولوا لنا، ولا خير فينا إذا لم نسمع منكم، رحم الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه.
فمع طلب البيان منه بهذه الصفة لا يتوهم أن يهابه أحد فلا يظهر عنده حكم الشرع مهابة له.
وحديث ذي اليدين رضي الله عنه قلنا مجرد السكوت عن النكير لا يكون دليل الموافقة عندنا، ولكن مع ترك إظهار ما هو الحق عنده بعد مضي مدة المهلة، ولم توجد هذه الصفة في حديث ذي اليدين، فإنه كما أظهر مقالته سأل رسول الله أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكان الكلام في الصلاة يومئذ مباحا فما كان هناك ما يمنعهم من الكلام، وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعرف ما عندهم من خلاف له أو وفاق، وذلك مستقيم قبل أن يحصل المقصود بالسكوت وإن كان يحصل ذلك بسكوتهم عن إظهار الخلاف أن لو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتمام الصلاة ولم يستنطقهم.
وكذلك ما قاله الكرخي رحمه الله فهو خارج على هذا الحرف، لانا لا نجعل مجرد السكوت عن النكير دليل الموافقة بل ترك إظهار ما عنده مما هو مخالف لما انتشر، وهذا واجب على كل مجتهد من علماء العصر، لا يباح له السكوت عنه بعد ما انتشر قول بخلاف قوله وبلغه ذلك، فإنما يحمل السكوت على الوجه الذي يحل له شرعا، ولهذا اعتبرنا في ثبوت الاجماع بهذا الطريق أن يسكت بعد عرض الفتوى عليه، لانه ما لم يبلغه قول هو مخالف لما عنده وما لم يسأل عنه لا يلزمه البيان، وإنما يكون ذلك بعد عرض الفتوى عليه وبعد مضي مدة المهلة أيضا لانه يحتاج إلى التروي وإلى رد الحادثة إلى الاشباه ليميز الاشبه بالحادثة من بين الاشباه برأيه، ولا يتأتى ذلك إلا بمدة، فإذا مضت المدة ولم يظهر خلاف ما بلغه كان ذلك دليلا على الوفاق باعتبار العادة.
فإن قيل: كان ينبغي أن لا تنتهي هذه المدة إلا بموته لان الانسان قد يكون متفكرا في شئ مدة عمره فلا يستقر فيه رأيه على شئ، وقد يرى رأيا في شئ ثم يظهر له رأي آخر فيرجع عن الاول، فعلى هذا مدة التروي لا تنتهي إلا بموته.
قلنا: لا كذلك بل إذا مضى من المدة ما يتمكن فيه من النظر والاجتهاد فعليه إظهار ما تبين له باجتهاده من توقف في الجواب أو خلاف أو وفاق لا يحل له السكوت عن الاظهار إلا عند الموافقة، وبعدما ثبت الاجماع بهذا الطريق فليس له أن يرجع عنه برأي يعرض له، لان الاجماع موجب للعلم قطعا بمنزلة النص فكما لا يجوز ترك العمل بالنص باعتبار رأي يعترض له لا يجوز مخالفة الاجماع برأي يعترض له بعدما انعقد الاجماع بدليله.
وكذلك إن لم يعرض عليه الفتوى ولكن اشتهر الفتوى في الناس على وجه يعلم أنه بلغ ذلك الساكتين من علماء العصر فإن ذلك يقوم مقام العرض عليهم لانه يجب عليهم إظهار الخلاف الذي عندهم إن كانوا يعتقدون خلاف ذلك
على وجه ينتشر هذا الخلاف منهم كما انتشر القول الاول، ليكون الثاني معارضا للاول، ولو أظهروا ذلك لانتشر، فسكوتهم عن الاظهار الثابت بدليل عدم الانتشار
دليل على الموافقة.
بهذا الطريق أثبتنا كون القرآن معجزا، لان العرب ما عارضوا بمثله ولو فعلوا لانتشر ذلك، وعجزهم عن المعارضة بعد التحدي دليل على أنه معجز.
فإن قيل: فقد اشتهر فتوى الناس بجواز المزارعة بعد أبي حنيفة قولا وفعلا مع سكوت أصحاب أبي حنيفة عن النكير ولم يكن ذلك دليل الموافقة.
قلنا: كما انتشر ذلك فقد انتشر أيضا الخلاف من أصحاب أبي حنيفة لمن أجاز المزارعة محاجة ومناظرة، وإنما تركوا التشنيع على من يباشر ذلك لانه ظهر عند الناس نوع رجحان لقول من أجازها فأخذوا بذلك، وذلك يمنع القائلين بفسادها من أن يظهروا منع الناس من ذلك لعلمهم أن الناس لا يمتنعون باعتبار ما ظهر لهم، بمنزلة القاضي إذا قضى في فصل مجتهد فيه فإنه لا يجب على المجتهد الذي يعتقد خلافه أن يظهر للناس خطأ القاضي، لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله، ولاعتقاده أن قضاء القاضي بما قضى به نافذ وأن ذلك الجانب ترجح بالقضاء، فترك النكير على من يباشر المزارعة بهذه المثابة.
يحقق ما قلنا إن من عادة المتشاورين من العوام في شئ يهمهم من أمر الدنيا ويتعلق به بعض مصالحهم أن البعض إذا أظهر فيه رأيا وعند البعض خلاف ذلك فإنهم لا يمتنعون من إظهار ما عندهم إلا نادرا ولا يبنى الحكم على النادر، فإذا كان هذا في أمر الدنيا مع أن السكوت عن الاظهار يحل فيه شرعا فلان يكون أمر الدين وما يرجع إلى إظهار حكم الله تعالى بهذه الصفة حتى يكون السكوت فيه دليل الوفاق كان أولى، فكذلك العادة من حال من يسمع ما هو مستبعد عنه أن لا يمتنع من إظهار النكير عنده، بل يكون ذلك جل همه، ألا ترى أنه لو أخبر مخبر أن الخطيب يوم الجمعة لما صعد المنبر رماه إنسان بسهم فقتله، وسمع ذلك منه قوم شهدوا الجمعة ولم
يعرفوا من ذلك شيئا، فإنه لا يكون في همتهم شئ أسبق من إظهار الانكار عليه، وقد بينا أن ما عليه العادة الظاهرة لا يجوز تركه في الاحكام، فتبين باعتبار هذه العادة أن السكوت دليل الموافقة، ونحن نعلم أنه قد كان عند الصحابة أن إجماعهم
حجة موجبة للعلم قطعا، فإذا علم الساكت هذا يفترض عليه بيان ما عنده ليتحقق الخلاف ويخرج ما اشتهر من أن يكون حكم الحادثة قطعا، والسكوت إن لم يدل على الموافقة فلا إشكال أنه لا يدل على الخلاف.
ومن هذا الجنس ما إذا اختلفوا في حادثة على أقاويل محصورة، فإن المذهب عندنا أن هذا يكون دليل الاجماع منهم على أنه لا قول في هذه الحادثة سوى هذه الاقاويل حتى ليس لاحد أن يحدث فيه قولا آخر برأيه.
وعند بعضهم هذا من باب السكوت الذي هو محتمل أيضا فكما لا يدل على نفي الخلاف لا يدل على نفي قول آخر في الحادثة فإن ذلك نوع تعيين ولا يثبت بالمحتمل.
ولكنا نقول: قد بينا أنهم إذا اختلفوا على أقاويل فنحن نعلم أن الحق لا يعدو أقاويلهم، وهذا بمنزلة التنصيص منهم على أن ما هو الحق حقيقة في هذه الاقاويل، وماذا بعد الحق إلا الضلال.
وكذلك هذا الحكم في اختلاف بين أهل كل عصر إلا على قول بعض مشايخنا، فإنهم يقولون هذا في أقاويل الصحابة خاصة لما لهم من الفضل والسابقة، ولكن المعنى الذي أشرنا إليه يوجب المساواة، وعلى هذا قالوا فيما ظهر من بعض الخلفاء عن الصحابة أنه قال في خطبته على المنبر، ولم يظهر من أحد منهم خلاف لذلك، فإن ذلك إجماع منهم بهذا الطريق.
وقد قال بعض من لا يعبأ بقوله: الاجماع الموجب للعلم قطعا لا يكون إلا في مثل ما اتفق عليه الناس من موضع الكعبة وموضع الصفا والمروة وما أشبه ذلك، وهذا ضعيف جدا، فإنه يقال لهذا القائل: بأي طريق عرفت إجماع المسلمين على هذا ؟ بطريق سماعك نصا من كل واحد من آحادهم ؟ فإن قال نعم ظهر
للناس كذبه، وإن قال لا ولكن بتنصيص البعض وسكوت الباقين عن إظهار الخلاف، فنقول كما ثبت بهذا الطريق الاجماع منهم على هذه الاشياء التي لا يشك فيها أحد فكذلك ثبت الاجماع منهم بهذا الطريق في الاحكام الشرعية.
فصل: الاهلية زعم بعض الناس أن الاجماع الموجب للعلم لا يكون إلا باتفاق فرق الامة أهل الحق وأهل الضلالة جميعا، لان الحجة إجماع الامة ومطلق اسم الامة يتناول الكل.
فأما المذهب عندنا أن الحجة اتفاق كل عالم مجتهد ممن هو غير منسوب إلى هوى ولا معلن بفسق في كل عصر، لان حكم الاجماع إنما يثبت باعتبار وصف لا يثبت إلا بهذه المعاني وذلك صفة الوساطة كما قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) وهو عبارة عن الخيار العدول المرضيين، وصفة الشهادة بقوله: (لتكونوا شهداء على الناس) فلا بد من اعتبار الاهلية لاداء الشهادة، وصفة الامر بالمعروف، وذلك يشير إلى فرضية الاتباع فيما يأمرون به وينهون عنه وإنما يفترض اتباع العدل المرضي فيما يأمر به، وثبوته بطريق الكرامة على الدين والمستحق للكرامات مطلقا من كان بهذه الصفة.
فأما أهل الاهواء فمن يكفر في هواه فاسم الامة لا يتناوله مطلقا ولا هو مستحق للكرامة الثابتة للمؤمنين، ومن يضلل في هواه إذا كان يدعو الناس إلى ما يعتقده فهو يتعصب لذلك على وجه يخرج به إلى صفة السفه والمجون فيكون متهما في أمر الدين لا معتبر بقوله في إجماع الامة، ولهذا لم يعتبر خلاف الروافض في إمامة أبي بكر، ولا خلاف الخوارج في خلافة علي.
فإن كان لا يدعو الناس إلى هواه ولكنه مشهور به، فقد قال بعض مشايخنا فيما يضلل هو فيه لا معتبر بقوله، لانه إنما يضلل لمخالفته نصا موجبا للعلم فكل قول كان بخلاف النص فهو باطل، وفيما سوى ذلك يعتبر قوله، ولا يثبت الاجماع مع مخالفته لانه من أهل الشهادة، ولهذا كان
مقبول الشهادة في الاحكام.
قال رضي الله عنه: والاصح عندي أنه إن كان متهما بالهوى ولكنه غير مظهر له فالجواب هكذا، فأما إذا كان مظهرا لهواه فإنه لا يعتد بقوله في الاجماع، لان المعنى الذي لاجله قبلت شهادته لا يوجد هنا فإنها تقبل لانتفاء تهمة الكذب، على ما قال محمد رحمه الله: قوم عظموا الذنوب حتى جعلوها كفرا لا يتهمون بالكذب في الشهادة.
وهذا يدل على أنهم لا يؤتمنون في أحكام الشرع ولا يعتبر قولهم فيه، فإن الخوارج هم الذين يقولون إن الذنب نفسه كفر وقد أكفروا أكثر الصحابة الذين عليهم مدار أحكام الشرع، وإنما عرفناها بنقلهم فكيف يعتمد قول هؤلاء في أحكام الشرع، وأدنى ما فيه أنهم لا يتعلمون ذلك، إذا كانوا يعتقدون كفر الناقلين.
ولا معتبر بقول الجهال في الاحكام، فأما من كان محقا في اعتقاده
ولكنه فاسق في تعاطيه فالعراقيون يقولون لا يعتد بقوله في الاجماع أيضا، لانه ليس بأهل لاداء الشهادة، ولان التوقف في قوله واجب بالنص وذلك ينفي وجوب الاتباع.
قال رضي الله عنه: والاصح عندي أنه إذا كان معلنا لفسقه فكذلك الجواب، لانه لما لم يتحرز من إعلان ما يعتقده باطلا فكذلك لا يتحرز من إعلان قول يعتقد بطلانه باطنا، فأما إذا لم يكن مظهرا للفسق فإنه يعتد بقوله في الاجماع وإن علم فسقه حتى ترد شهادته، لانه لا يخرج بهذا من الاهلية للشهادة أصلا ولا من الاهلية للكرامة بسبب الدين، ألا ترى أنا نقطع القول لمن يموت مؤمنا مصرا على فسقه أنه لا يخلد في النار، فإذا كان هو أهلا للكرامة بالجنة في الآخرة فكذلك في الدنيا باعتبار قوله في الاجماع.
فأما كونه عالما مجتهدا فهو معتبر في الحكم الذي يختص بمعرفته والحاجة إليه العلماء، وعلى هذا قلنا: من يكون متكلما غير عالم بأصول الفقه والادلة الشرعية في الاحكام لا يعتد بقوله في الاجماع.
هكذا نقل عن الكرخي.
وكذلك من يكون محدثا لا بصر له في وجوه الرأي وطرق المقاييس
الشرعية لا يعتد بقوله في الاجماع، لان هذا فيما يبني عليه حكم الشرع بمنزلة العامي ولا يعتد بقول العامي في إجماع علماء العصر، لانه لا هداية له في الحكم المحتاج إلى معرفته، فهو بمنزلة المجنون حتى لا يعتد بمخالفته.
ثم قال بعض العلماء الذين هم بالصفة التي قلنا من أهل العصر: ما لم يبلغوا حدا لا يتوهم عليهم التواطؤ على الباطل لا يثبت الاجماع الموجب للعلم باتفاقهم، ألا ترى أن حكم التواتر لا يثبت بخبرهم ما لم يبلغوا هذا الحد، فكذلك حكم الاجماع بقولهم، لان بكل واحد منهما يثبت علم اليقين.
والاصح عندنا أنهم إذا كانوا جماعة واتفقوا قولا أو فتوى من البعض مع سكوت الباقين فإنه ينعقد الاجماع به وإن لم يبلغوا حد التواتر، بخلاف الخبر فإن ذلك محتمل للصدق والكذب فلا بد من مراعاة معنى ينتفي به تهمة الكذب بكثرتهم، ألا ترى أن صفة العدالة لا تعتبر هناك، وهذا إظهار حكم ابتداء ليس فيه من معنى احتمال تهمة الكذب شئ إنما فيه توهم الخطأ، فإذا كانوا جماعة فالامن عن ذلك ثابت شرعا كرامة لهم بسبب الدين وصفة العدالة على ما قررنا.
فإن قيل لا يؤمن على هؤلاء إعلان الفسق أو الضلالة أو الردة مثلا بعدما انعقد الاجماع منهم، فكيف يؤمن الخطأ باعتبار اجتماعهم ؟ وعن هذا الكلام جوابان لمشايخنا رحمهم الله: أحدهما أنا لا نجوز هذا على جماعتهم بعدما كان إجماعهم موجبا للعلم في حكم الشرع فإن الله تعالى يعصمهم من ذلك، لان إجماعهم صار بمنزلة النص عن صاحب الشريعة، فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن هذا نقطع القول به، لان قوله موجب للعلم، فكذلك جماعة العلماء إذا ثبت لهم هذه الدرجة، وهو أن قولهم موجب للعلم كرامة بسبب الدين.
والثاني أنه وإن تحقق هذا منهم فإن الله تعالى يقيم آخرين مقامهم ليكون الحكم ثابتا بإجماعهم، لان الدين محفوظ إلى
قيام الساعة على ما قال رسول الله عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله فما يعترض على الاولين لا يؤثر في حكم الاجماع لقيام أمثالهم مقامهم، بمنزلة موتهم.
وقال بعض العلماء: الاجماع الموجب للعلم لا يكون إلا بإجماع الصحابة الذين كانوا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لانهم صحبوه وسمعوا منه علم التنزيل والتأويل، وأثنى عليهم في آثار معروفة فهم المختصون بهذه الكرامة.
وهذا ضعيف عندنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أثنى عليهم فقد أثنى على من بعدهم فقال: خير الناس قرني الذين أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ففي هذا بيان أن أهل كل عصر يقومون مقامهم في صفة الخيرية إذا كانوا على مثل اعتقادهم، والمعاني التي بيناها لاثبات هذا الحكم بها من صفة الوساطة والشهادة والامر بالمعروف لا يختص بزمان ولا بقوم، وثبوت هذا الحكم بالاجماع لتحقيق بقاء حكم الشرع إلى قيام الساعة وذلك لا يتم ما لم يجعل إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة رضي الله عنهم.
فإن قيل: ف أبو حنيفة رحمه الله قال بخلاف هذا لانه قال: ما جاءنا عن الصحابة اتبعناهم، وما جاءنا عن التابعين زاحمناهم.
قلنا: إنما قال ذلك لانه كان من جملة التابعين
فإنه رأى أربعة من الصحابة: أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى، وأبو الطفيل، و عبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنهم، وقد كان ممن يجتهد في عهد التابعين ويعلم الناس حتى ناظر الشعبي في مسألة النذر بالمعصية فما كان ينعقد إجماعهم بدون قوله فلهذا قال ذلك لا لانه كان لا يرى إجماع من بعد الصحابة حجة.
ومن الناس من يقول: الاجماع الذي هو حجة إجماع أهل المدينة خاصة لانهم أهل حضرة الرسول وقد بين رسول الله عليه السلام خصوصية تلك البقعة في آثار فقال:
إن الاسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وقال عليه السلام: إن الدجال لا يدخلها وقال عليه السلام: من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء وقال عليه السلام: إن المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد ولكن ما قررنا من المعاني لا يختص بمكان دون مكان.
ثم إن كان مراد القائل أهلها الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينازع فيه أحد، وإن كان المراد أهلها في كل عصر فهو قول باطل، لانه ليس في بقعة من البقاع اليوم في دار الاسلام قوم هم أقل علما وأظهر جهلا وأبعد عن أسباب الخير من الذين هم بالمدينة فكيف يستجاز القول بأنه لا إجماع في أحكام الدين إلا إجماعهم ؟ والمراد بالآثار حال المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت الهجرة فريضة كان المسلمون يجتمعون فيها وأهل الخبث والردة لا يقرون فيها، وقد تكون البقعة محروسة وإن كان من يسكنها على غير الحق، ألا ترى أن مكة كانت محروسة عام الفيل مع أن أهلها كانوا مشركين يومئذ.
ومن الناس من يقول لا إجماع إلا لعترة الرسول لانهم المخصوصون بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسباب العز، قال عليه السلام: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي وقال تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) .
ولكنا نقول: أنواع الكرامة لاهل البيت متفق عليه، ولكن حكم الاجماع الموجب للعلم باعتبار نصوص ومعاني لا يختص ذلك بأهل البيت، والنسب ليس من ذلك في شئ فالتخصيص به يكون زيادة، كيف وقد قال تعالى: (واتبع سبيل من أناب إلي) فكل من كان منيبا إلى ربه فهو داخل في هذه الآية، وهو مراد بقوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) كما ذكرنا من الاستدلال به.
فصل: الشرط زعم بعض الناس أن انقراض العصر شرط لثبوت حكم الاجماع.
وهو قول الشافعي رحمه الله أيضا، لان قبل انقراض العصر إذا بدا لبعضهم رأي خلاف رأي الجماعة فإن ما ظهر له في الانتهاء بمنزلة الموجود في الابتداء ولو كان موجودا لم ينعقد إجماعهم بدون قوله، فكذلك إذا اعترض له ذلك، ولا يقع الامن عن هذا إلا بانقراض العصر على ذلك الاجماع، ألا ترى أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسوي بين الناس في العطايا وكانوا لا يخالفونه في ذلك، ثم فضل علي رضي الله عنه في العطايا في خلافته ولا يظن به مخالفة الجماعة، فعرفنا أن بدون انقراض العصر لا يثبت حكم الاجماع، وقال علي رضي الله عنه: اتفق رأيي ورأي عمر على أن أمهات الاولاد لا يبعن، وأنهن أحرار عن دبر من الموالي، ثم رأيت أن أرقهن.
فلو ثبت الاجماع قبل انقراض العصر لما استجاز خلاف الاجماع برأيه.
وأما عندنا انقراض العصر ليس بشرط، لان الاجماع لما انعقد باعتبار اجتماع معاني الذي قلنا كان الثابت به كالثابت بالنص، وكما أن الثابت بالنص لا يختص بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالاجماع، ولو شرطنا انقراض العصر لم يثبت الاجماع أبدا لان بعض التابعين في عصر الصحابة كان يزاحمهم في الفتوى فيتوهم أن يبدو له رأي بعد أن لم يبق أحد من الصحابة، وهكذا في القرن الثاني والثالث فيؤدي إلى سد باب حكم الاجماع (أصلا) وهذا باطل.
ولكنا نقول: بعد ما ثبت الاجماع موجبا للعلم باتفاقهم فليس لاحد أن يظهر خلاف ذلك برأيه لا من
أهل ذلك العصر ولا من غيرهم، كما لا يكون له أن يخالف النص برأيه وهذا بخلاف رأيه قبل انعقاد الاجماع، لان الدليل الموجب للعلم لم يتقرر هناك فكان قوله معتبرا في منع انعقاد الاجماع.
وأما حديث التسوية في العطاء فقد كان مختلفا في الابتداء
على ما روي عن عمر رضي الله عنه قال لابي بكر: لا تجعل من لا سابقة له في الاسلام كمن له سابقة.
فقال أبو بكر: هم إنما عملوا لله فأجرهم على الله.
فتبين أن هذا الفصل كان مختلفا في الابتداء فلهذا مال علي رضي الله عنه إلى التفضيل.
وحديث أمهات الاولاد فالمروي أن عليا رضي الله عنه قال: ثم رأيت أن أرقهن.
يعني أن لا أعتقهن بموت المولى حتى يكون الوارث أو الوصي هو المعتق لها كما دل عليه ظاهر بعض الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس المراد جواز بيعهن إذ ليس من ضرورة الرق جواز البيع لا محالة.
وكان الكرخي رحمه الله يقول: شرط الاجماع أن يجتمع علماء العصر كلهم على حكم واحد، فأما إذا اجتمع أكثرهم على شئ وخالفهم واحد أو اثنان لم يثبت حكم الاجماع.
وهذا قول الشافعي رحمه الله أيضا، لان النبي عليه السلام قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ولانه لا معتبر بالقلة والكثرة في المعنى الذي يبتنى عليه حكم الاجماع، وبالاتفاق لو كان فريق منهم على قول وفريق مثلهم على قول آخر فإنه لا يثبت حكم الاجماع، فكذلك إذا كان أكثرهم على قول ونفر يسير منهم على خلاف ذلك لا يثبت حكم الاجماع.
قال رضي الله عنه: والاصح عندي ما أشار إليه أبو بكر الرازي رحمه الله أن الواحد إذا خالف الجماعة فإن سوغوا له ذلك الاجتهاد لا يثبت حكم الاجماع بدون قوله، بمنزلة خلاف ابن عباس للصحابة في زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للام ثلث جميع المال، وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا (عليه) قوله فإنه يثبت حكم الاجماع بدون قوله، بمنزلة قول ابن عباس في حل التفاضل في أموال الربا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يسوغوا له هذا الاجتهاد حتى روي أنه رجع إلى قولهم فكان الاجماع ثابتا بدون قوله، ولهذا قال محمد رحمه الله في الاملاء: لو قضى القاضي
بجواز بيع الدرهم بالدرهمين لم ينفذ قضاؤه لانه مخالف للاجماع.
والدليل على صحة
هذا القول قوله عليه السلام: يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في النار.
وقال عليه السلام: عليكم بالسواد الاعظم يعني ما عليه عامة المؤمنين، ففي هذا إشارة إلى أن قول الواحد لا يعارض قول الجماعة، ولانا لو شرطنا هذا أدى إلى أن لا ينعقد الاجماع أبدا لانه لا بد أن يكون في علماء العصر واحد أو اثنان ممن لم يسمع ذلك الفتوى أصلا وممن يرى خلاف ذلك.
وإنما كان الاجماع حجة باعتبار ظهور وجه الصواب فيه بالاجتماع عليه، وإنما يظهر هذا في قول الجماعة لا في قول الواحد، ألا ترى أن قول الواحد لا يكون موجبا للعلم وإن لم يكن بمقابلته جماعة يخالفونه وقول الجماعة موجب للعلم إذا لم يكن هناك واحد يخالفهم، فكذلك مع وجود هذا الواحد، لان قوله لا يعارض قولهم، بخلاف ما إذا كان على كل قول جماعة فهناك المعارضة تتحقق، والمراد من قوله عليه السلام: بأيهم اقتديتم اهتديتم إذا لم يكن هناك دليل موجبا للعلم، بخلاف قول من يهتدي به، ألا ترى أنه إذا كان هناك نص بخلاف قول الواحد لم يجز اتباعه ولم يكن هذا الحديث متناولا له.
وحكي عن أبي حازم القاضي رحمه الله أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شئ فذلك إجماع موجب للعلم ولا يعتد بخلاف من خالفهم في ذلك لقوله عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ولهذا لم يعتبر خلاف زيد للخلفاء في توريث ذوي الارحام، وأمر المعتصم برد الاموال التي اجتمعت في بيت المال مما أخذت من تركات فيها ذوو الارحام فأنكر ذلك عليه أبو سعيد البردعي رحمه الله وقال: هذا شئ أمضى على قول زيد، فقال: لا أعتد خلاف زيد في مقابلة قول الخلفاء الراشدين، وقد قضيت بذلك فليس لاحد أن يبطله بعدي.
فصل: الحكم ذكر هشام عن محمد رحمهما الله: الفقه أربعة، ما في القرآن وما أشبهه،
وما جاءت به السنة وما أشبهها، وما جاء عن الصحابة وما أشبهه، وما رآه المسلمون حسنا وما أشبهه.
ففي هذا بيان أن ما أجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الثابت بالكتاب والسنة، في كونه مقطوعا به حتى يكفر جاحده.
وهذا أقوى ما يكون من الاجماع، ففي الصحابة أهل المدينة وعترة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا خلاف بين من يعتد بقولهم إن هذا الاجماع حجة موجبة للعلم قطعا فيكفر جاحده كما يكفر جاحد ما ثبت بالكتاب أو بخبر متواتر.
فإن قيل: كيف يستقيم هذا وتوهم الخطأ لم ينعدم بإجماعهم أصلا، فإن رأيهم لا يكون فوق رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال تعالى: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) وقال تعالى: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى) الآية، ففي هذا إشارة إلى أنه قد كان وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخطأ في بعض ما فعل به برأيه، فعرفنا أنه لا يؤمن الخطأ في رأي دون رأيه أصلا ؟ قلنا: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن التقرير على الخطأ خصوصا في إظهار أحكام الدين، ولهذا كان قوله موجبا علم اليقين، واتباعه فرض على الامة، قال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وسنقرر هذا الكلام في موضعه (إن شاء الله تعالى) فإذا ثبت هذا فيما ثبت بتنصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك فيما يثبت بإجماع الصحابة، فإنه لا يبقى فيه توهم الخطأ بعد إجماعهم حتى يكفر جاحده.
وقوله وما أشبهه المراد منه أن الصحابة إذا اختلفوا في حادثة على أقاويل فإن ذلك اتفاق
منهم على أنه لا قول سوى ما ذكروا فيها وأن الحق لا يعدو أقاويلهم حتى ليس لاحد بعدهم أن يخترع قولا آخر برأيه، ولهذا قلنا إن الصحابة لما اختلفوا في مقدار جعل الآبق على أقاويل كان ذلك اتفاقا منهم على أن الحق لا يعدو أقاويلهم، فليس لاحد بعدهم أن يخترع فيه قولا آخر برأيه، إلا أن هذا الاجماع دون الاول في الحكم
لان ثبوته بطريق الاستدلال وأصله مسكوت عنه فلا يكفر جاحده مثل هذا الاجماع.
فإن قيل: أليس أنكم قلتم فيمن قال لامرأته اختاري فإن اختارت نفسها وقعت تطليقة بائنة، وإن اختارت زوجها لم يقع شئ، وقد كانت الصحابة فيها على قولين سوى هذا ثم اخترعتم قولا ثالثا برأيكم ؟ قلنا: ما فعلنا ذلك فإن الكرخي رحمه الله ذكر مذهبنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه فليس ذلك بخروج عن أقاويلهم، وفي قوله ما رآه المسلمون حسنا بيان أن إجماع أهل كل عصر حجة، ولكن هذا في الحكم دون ما سبق، وهو بمنزلة خبر مشهور حتى لا يكفر جاحده، ولكن يجوز النسخ به لان بين من يعتد بقولهم من العلماء اختلافا فيه، ودون هذا بدرجة أيضا الاجماع بعد الاختلاف في الحادثة، إذا كانت مختلفا فيها في عصر ثم اتفق أهل عصر آخر بعدهم على أحد القولين، فقد قال بعض العلماء: هذا لا يكون إجماعا، وعندنا هو إجماع ولكنه بمنزلة خبر الواحد في كونه موجبا للعمل غير موجب للعلم.
قال رضي الله عنه: وكان شيخنا (الامام الحلواني رحمه الله) يقول: هذا على قول محمد رحمه الله يكون إجماعا، فأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا يكون إجماعا، فإن الرواية محفوظة عن محمد رحمه الله أن قضاء القاضي بجواز بيع أم الولد باطل، وقد كان هذا مختلفا فيه بين الصحابة ثم اتفق من بعدهم على أنه لا يجوز بيعها فكان هذا قضاء بخلاف الاجماع عند محمد، وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ينفذ قضاء القاضي به لشبهة الاختلاف في الصدر الاول، ولا يثبت الاجماع مع وجود الاختلاف في الصدر الاول.
قال رضي الله عنه:
والاوجه عندي أن هذا إجماع عند أصحابنا جميعا للدليل الذي دل على أن إجماع أهل كل عصر إجماع معتبر، وإنما ينفذ قضاء القاضي بجواز بيعها لشبهة الاختلاف في أن مثل هذا هل يكون إجماعا ؟ فعلى اعتبار هذه الشبهة يكون قضاؤه في مجتهد
فيه، فلهذا نفذه أبو حنيفة رحمه الله.
وجه قول الفريق الاول أن الحجة إجماع الامة والذي كان مخالفا في الصدر الاول من الامة وبموته لا يبطل قوله فلا يثبت الاجماع بدون قوله، ألا ترى أنه لو بقي حيا إلى هذا الوقت لم ينعقد الاجماع بدون قوله، فكذلك إذا كان ميتا، لان اعتبار قوله لدليله لا لحياته، ولانه لو ثبت الاجماع بعده لوجب القول بتضليله، ولا نظن أحدا يقول هذا لابن عباس رضي الله عنهما في زوج وأبوين وإن أجمعوا بعده على خلاف قوله، ولا لابن مسعود رضي الله عنه في تقديم ذوي الارحام على مولى العتاقة وإن أجمعوا بعده على خلاف قوله، وقد قلتم إذا قال لامرأته أنت خلية ونوى ثلاثا ثم وطئها في العدة وقال علمت أنها علي حرام لا يلزمه الحد، لان عمر رضي الله عنه كان يراها تطليقة رجعية وقد أجمعوا بعده على خلاف ذلك ولهذا صح نية الثلاث فيه، فدل أن الاجماع لا يثبت بمثل هذا.
وجه قولنا إن المعتبر إجماع أهل كل عصر لما بينا أن المقصود كون أحكام الشرع محفوظة وأن ثبوت هذا الحكم باعتبار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك يختص به الاحياء من أهل العصر دون من مات قبلهم فكما أن لا يعتبر توهم قول ممن يأتي بعدهم بخلاف قولهم في منع ثبوت حكم الاجماع فكذلك لا يعتبر قول واحد كان قبلهم إذا اجتمعوا في عصرهم على خلافه، ويجعل هذا الاجماع بمنزلة التقدير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لو عرض عليه الفتوى، ومعلوم أنه لو عرض عليه فقال: الصواب هذا فإنه تثبت الحجة به ولا يضلل القائل بخلافه قبل هذا التنصيص، فكذلك هنا لا يضلل القائل بخلافه قبل هذا الاجماع، ألا ترى أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعدما نزلت فرضية التوجه إلى الكعبة حتى أتاهم آت فأخبرهم واستداروا
كهيئتهم وجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتهم، لان ذلك كان قبل
العلم بالنص الناسخ، وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بإباحة المتعة ثم رجع إلى قول الصحابة، ويثبت الاجماع برجوعه لا محالة ولم يكن ذلك موجبا تضليله فيما كان يفتي به قبل هذا.
فأما ما إذا قال لامرأته أنت خلية فإنما أسقطنا الحد هناك بالوطئ لا لان اتفاق أهل العصر بعد الخلاف ليس بإجماع ولكن للشبهة المتمكنة في هذا الاجماع بسبب اختلاف العلماء، فإن الحد يسقط بأدنى شبهة، والله أعلم بالحقيقة.
باب: الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها قال فقهاء الامصار رحمهم الله: خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم اليقين.
وقال بعض من لا يعتد بقوله: خبر الواحد لا يكون حجة في الدين أصلا.
وقال بعض أهل الحديث: يثبت بخبر الواحد علم اليقين، منهم من اعتبر فيه عدد الشهادة ليكون حجة، ومنهم من اعتبر أقصى عدد الشهادة وهو الاربعة.
فأما الفريق الاول استدلوا بقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) وإذا كان خبر الواحد لا يوجب العلم لم يجز اتباعه والعمل به بهذا الظاهر، وقال تعالى: (ولا تقولوا على الله إلا الحق) وخبر الواحد إذا لم يكن معصوما عن الكذب (محتمل للكذب) والغلط فلا يكون حقا على الاطلاق ولا يجوز القول بإيجاب العمل به في الدين، وقال تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) وقال تعالى: (وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) ومعنى الصدق في خبر الواحد غير ثابت إلا بطريق الظن، ولان خبر الواحد محتمل للصدق والكذب والنص الذي هو محتمل لا يكون موجبا للعمل بنفسه مع أن كل واحد من المحتملين فيه يجوز أن يكون شرعا، فلان لا يجوز العمل بما هو محتمل للكذب والكذب باطل أصلا كان أولى.
ولا يدخل على ما ذكرنا أمور المعاملات، لان الذي يترتب عليها حقوق العباد
والعباد يعجزون عن إظهار كل حق لهم بطريق لا يبقى فيه شك وشبهة، فلاجل الضرورة جوزنا الاعتماد فيها على خبر الواحد، ولهذا سقط اعتبار اشتراط العدالة فيه أيضا، فأما هنا الثابت ما هو حق لله، والله موصوف بكمال القدرة يتعالى عن أن يلحقه ضرورة أو عجز عن إظهار حقوقه بما لا يبقى فيه شك وشبهة، فلهذا لا يجعل المحتمل للصدق والكذب حجة فيه.
وعلى هذا تخرج الشهادات أيضا فإن القياس فيها أن لا يكون حجة مع بقاء احتمال الكذب تركناه بالنصوص وبالمعنى الذي أشرنا إليه أنها مشروعة لاثبات حقوق العباد، والحاجة إليها تتجدد للعباد في كل وقت وهم يعجزون عن إثبات كل حق لهم بما لا يكون محتملا، ولان القول بما قلتم يؤدي إلى أن يزداد درجة المخبر الذي هو غير معصوم عن الكذب على المخبر المعصوم عن الكذب، يعني من ينزل عليه الوحي، فإن خبره في أول أمره إنما كان واجب القبول باقتران المعجزات به، فمن يقول بأن خبر غيره يكون مقبولا من غير دليل يقترن به فقد زاد درجة هذا المخبر على درجة الرسول، وأي قول أظهر فسادا من هذا ! ولا خلاف أن أصل الدين كالتوحيد وصفات الله وإثبات النبوة لا يكون إلا بطريق يوجب العلم قطعا ولا يكون فيه شك ولا شبهة، فكذلك فيما يكون من أمر الدين.
وحجتنا في ذلك قوله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات) الآية، وقال تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس) الآية، ففي هاتين الآيتين نهى لكل واحد عن الكتمان، وأمر بالبيان على ما هو الحكم في الجمع المضاف إلى جماعة أنه يتناول كل واحد منهم، ولان أخذ الميثاق من أصل الدين، والخطاب للجماعة بما هو أصل الدين يتناول كل واحد من الآحاد، ومن ضرورة توجه الامر بالاظهار على كل واحد أمر السامع بالقبول منه والعمل به، إذ أمر الشرع لا يخلو عن فائدة حميدة ولا فائدة في النهي عن الكتمان، والامر بالبيان سوى
هذا.
ولا يدخل عليه الفاسق فإنه داخل في عموم الامر بالبيان ثم لا يقبل بيانه في الدين، لانه مخصوص من هذا النص بنص آخر وهو ما فيه أمر بالتوقف في خبر الفاسق، ثم هو مزجور عن اكتساب سبب الفسق مأمور بالتوبة عنه ثم يترتب البيان عليه، فعلى هذا الوجه بيانه يفيد وجوب القول والعمل به، وقال تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) الآية، والفرقة اسم للثلاثة فصاعدا، فالطائفة من الفرقة
بعضها وهو الواحد أو الاثنان، ففي أمر الطائفة بالتفقه والرجوع إلى قومهم للانذار كي يحذروا، تنصيص على أن القبول واجب على السامعين من الطائفة، وأنه يلزمهم الحذر بإنذار الطائفة، وذلك لا يكون إلا بالحجة، ولا يقال الطائفة اسم للجماعة لان المتقدمين اختلفوا في تفسير الطائفة.
قال محمد بن كعب: هو اسم للواحد.
وقال عطاء: اسم للاثنين.
وقال الزهري: لثلاثة.
وقال الحسن: لعشرة، فيكون هذا اتفاقا منهم أن الاسم يحتمل أن يتناول كل واحد من هذه الاعداد، ولم يقل أحد بالزيادة على العشرة، ومعلوم أن بخبر العشرة لا ينتفي توهم الكذب ولا يخرج من أن يكون محتملا، فعرفنا أنه لا يشترط لوجوب العمل كون المخبر بحيث لا يبقى في خبره تهمة الكذب.
ثم الاصح ما قاله محمد بن كعب، فقد قال قتادة في قوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة) الواحد فصاعدا، وقال تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) نقل في سبب النزول أنهما كانا رجلين، وفي سياق الآية ما يدل عليه فإنه قال تعالى: (فأصلحوا بينهما) ولم يقل بينهم، وقال: (فأصلحوا بين أخويكم) فقد سمي الرجلين طائفتين.
فإن قيل: هذا بعيد فإن هاء التأنيث لا تلحق بنعت الواحد من الذكور.
قلنا: هذا عند ذكر الرجل فأما عند ذكر النعت يصلح للفرد من الذكور والاناث، فللعرب عادة في إلحاق هاء التأنيث به وكتاب الله يشهد به، قال تعالى: (وإن تدع مثقلة إلى
حملها لا يحمل منه شئ) والمراد الواحد لا من الاناث خاصة بدليل قوله تعالى: (ولو كان ذا قربى) .
فإن قيل: هذا خطاب لجميع الطوائف بالانذار وهم يبلغون حد التواتر ويكون خبرهم مستفيضا مشتهرا.
قلنا: لا كذلك فالجمع المضاف إلى جماعة يتناول كل واحد منهم كقول القائل: لبس القوم ثيابهم، وفي قوله تعالى: (إذا رجعوا إليهم) ما يدل على ما قلنا، لان الرجوع إنما يتحقق ممن كان خارجا من القوم ثم صار قادما عليهم وإتيان جميع الطوائف إلى كل قوم للانذار لا يكون رجوعا إليهم مع أن هذا لو كان شرطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وكلفهم أن يفعلوه، ولو فعلوه
لاشتهر ولم ينقل شئ من ذلك في الآثار، والذي يتحقق بهم الاجماع للدوران للانذار لا ينقطع توهم الكذب عن خبرهم لبقاء احتمال التواطؤ بينهم، فكان الاستدلال قائما وإن ساعدناهم على هذا التأويل.
فإن قيل: عندنا الراجع إلى كل فريق مأمور بالانذار بما سمعه لقومه، وإن لم يكن عليهم أن يقبلوا ذلك منه، بل المقصود أن يشتهر ذلك وعند الاشتهار تنتفي تهمة الكذب فتصير حجة حينئذ، بمنزلة الشاهد الواحد فإنه مأمور بأداء الشهادة، وإن كان العمل بشهادته لا يجب ما لم يتم العدد بشاهد آخر وتظهر العدالة بالتزكية.
قلنا: الشاهد إذا كان وحده فليس عليه أداء الشهادة، لان ذلك لا ينفع المدعي وربما يضر بالشاهد فلو لم يكن خبر الواحد حجة لوجوب العمل لما وجب الانذار بما سمع، ثم لما ثبت بالنص أنه مأمور بالانذار ثبت أنه يجب القبول منه، لانه في هذا بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان مأمورا بالانذار ثم كان قوله ملزما للسامعين، كيف وقد بين الله تعالى حكم القبول والعمل به في إشارة بقوله: (لعلهم يحذرون) : أي لكي يحذروا عن الرد والامتناع عن العمل بعد لزوم الحجة إياهم، كما قال تعالى:
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره) والامر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة.
فدل أن خبر الواحد موجب للعمل، ولان النبي عليه السلام كان مبعوثا إلى الناس كافة، قال تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس) وقد بلغ الرسالة بلا خلاف ومعلوم يقينا أنه ما أتى كل أحد فبلغه مشافهة، ولكنه بلغ قوما بنفسه، وآخرين برسول أرسل إليهم، وآخرين بكتاب، وكتابه إلى ملوك الآفاق مشهور لا يمكن إنكاره، فلو لم يكن خبر الواحد حجة لما كان مبلغا رسالات ربه بهذا الطريق إلى الناس كافة، وقد فتحت البلدان النائية على عهده كاليمن والبحرين وهو ما أتاهم بنفسه ولكنه بعث عاملا إلى كل ناحية ليعلمهم الاحكام، على ما هو سير الملوك اليوم في بعث العمال إلى البلدان لاجل أمور الدنيا، فلو لم يكن خبر الواحد حجة في أمور الدين لما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الذين آمنوا وكانوا بالبعد من
حضرته، وكذلك المخدرات في بيوتهن لم يحضرن مجلسه في كل حادثة ولكن أزواجهن كانوا يسمعون أحكام الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجعون إليهن ويعلمونهن، فلو لم يكن خبر الواحد حجة لكلفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتيان إليه للسماع منه ولو فعل ذلك لاشتهر، ولا يقال إنما اكتفى بذلك لان من بعثه رسول الله معلما إلى قوم لا يقول لهم إلا ما هو حق صدق فكان ذلك كرامة لرسول الله ولا يوجد مثل ذلك في حق غيرهم من المخبرين، لانه لو كان بهذه الصفة لنقل هذا السبب كرامة لهم ولاعقابهم، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص واحدا من الصحابة بشئ اشتهر ذلك بالنقل، نحو قوله في حنظلة رضي الله عنه إن الملائكة غسلته، وفي جعفر رضي الله عنه إن له جناحين يطير بهما في الجنة.
ثم كما أن من بعثه رسول الله عليه السلام خليفته في التبليغ فكل من سمع شيئا في أمر الدين فهو خليفته في التبليغ مأمور من جهته بالبيان كالمبعوث لقوله عليه
الصلاة والسلام: ألا فليبلغ الشاهد الغائب ولقوله عليه السلام: نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها كما سمعها ثم أداها إلى من يسمعها، فرب حامل فقه إلى غير فقيه، ورب حامل فقه إلى ما هو أفقه منه فينبغي أن يثبت ترجح جانب الصدق في خبر كل عدل أيضا كرامة لرسول الله عليه السلام.
وفي قوله: (فرب حامل فقه) بيان أن ما يخبر به الواحد فقه والفقه في الدين ما يكون حجة، ولانا نعلم أنه عليه السلام كان يأكل الطعام وما كان يزرع بنفسه ليتيقن بصفة الحل فيما يأكله وقد كان مأمورا بأكل الطيب، قال تعالى: (يأيها الرسل كلوا من الطيبات) وربما كان يهدي إليه على ما روي أن سلمان رضي الله عنه أهدي إليه طبقا من رطب، وأن بريرة رضي الله عنها كانت تهدي إليه، وكان يدعى إلى طعام، فلو لم يكن خبر الواحد حجة للعمل به في حق الله تعالى لما اعتمد ذلك فيما يأكله، ولا يقال: كان يعلم من طريق الوحي حل ما يتناوله لانه ما كان منتظر الوحي عند أكله، ألا ترى أنه تناول لقمة من الشاة المصلية
فلما لم يسغها سأل عن شأنها فأخبر بذلك فأمر بالتصدق بها، وتناول لقمة من الشاة المسمومة، فعرفنا أنه ما كان ينتظر الوحي عند كل أكلة.
والذي يؤيد ما قلنا حكم الشهادات، فإن الله تعالى أمر القاضي بالقضاء بالشهادة، ومعلوم أن الاحتمال يبقى بعد شهادة شاهدين، فلو كان شرط وجوب العمل بالخبر انتفاء تهمة الكذب من كل وجه لما وجب على القاضي القضاء بالشهادة مع بقاء هذا الاحتمال.
فإن قيل: الشهادات لاظهار حقوق العباد وقد بينا أن هذا الشرط غير معتبر فيما هو من حقوق العباد.
قلنا: كما يجب القضاء بما هو من حقوق العباد عند أداء الشهادة يجب القضاء بما هو من حقوق الله تعالى كحد الشرب والسرقة والزنا، ثم وجوب القضاء بالشهادة من حقوق الله تعالى حتى إذا امتنع من غير عذر يفسق، وإذا لم ير ذلك أصلا يكفر، إلا أن سببه حق العبد وبه لا يخرج من أن يكون حقا لله تعالى
كالزكاة، فإنها تجب حقا لله تعالى بسبب مال هو حق العبد.
وقد يترتب على خبر الواحد في المعاملات ما هو حق الله تعالى نحو الاخبار بطهارة الماء ونجاسته، والاخبار بأن هذا الشئ أهداه إليك فلان، وأن فلانا وكلني ببيع هذا الشئ، فإنه يترتب على هذا كله ما هو حق الله تعالى وهو إباحة التناول، فإن الحل والحرمة من حق الله، ولا يظن بأحد أنه لا يرى الاعتماد في مثل هذا على خبر الواحد فإنه يتعذر به على الناس الوصول إلى حوائجهم، ألا ترى أنه وإن أخبره أن العين ملكه ببيعه فمن الجائز أنه غاصب، وإذا ألجأته الضرورة إلى التسليم في هذا يقاس عليه ما سواه.
ويتبين به فساد اشتراط انتفاء تهمة الكذب عن الخبر للعمل به فيما هو من حق الله تعالى، وبهذا يتبين خطأ من زعم أن هذا عمل بغير علم، فإنه عندنا عمل بعلم هو ثابت من حيث الظاهر ولكنه غير مقطوع به، وقد سمى الله تعالى مثله علما فقال: (وما شهدنا إلا بما علمنا) وإنما قالوا ذلك سماعا من مخبر أخبرهم به، وقال: (فإن علمتوهن مؤمنات) وإنما قال ذلك باعتبار غالب الرأي واعتماد نوع من الظاهر، فدل على أن مثله علم لا ظن إنما الظن عند خبر الفاسق، ولهذا أمر الله بالتوقف في خبره
وبين المعنى فيه بقوله: (أن تصيبوا قوما بجهالة) فيكون ذلك بيانا أن من اعتمد خبر العدل في العمل به يكون مصيبا بعلم لا بجهالة إلا أن ذلك (علم) باعتبار الظاهر لان عدالته ترجح جانب الصدق في خبره، وإذا كان هذا النوع من الظاهر يصلح حجة للقضاء به فلان يصلح حجة للعمل به في أمر الدين كان أولى، لان هذا الحكم أسرع ثبوتا، ألا ترى أن بالقياس يثبت، ومعلوم أن هذا الاحتمال في القياس أظهر، والقياس دون خبر الواحد، ومن لا يجوز العمل بخبر الواحد هنا يفزع إلى القياس، فكيف يستقيم ترك العمل بما هو أقوى لبقاء احتمال فيه والفزع إلى ما هو دونه وهذا الاحتمال فيه أظهر ؟
فإن قيل: هذا سهو، فإن الكلام في إثبات الحكم ابتداء والقياس لا يصلح لنصب الحكم ابتداء، وإنما ذلك بالسماع ممن ينزل عليه الوحي وقد كان معصوما عن مثل هذا الاحتمال في خبره، فعرفنا أنه لا يثبت الحكم ابتداء إلا بخبر يضاهي السماع منه، وذلك بأن يبلغ حد التواتر، إلا أن في القضاء تركنا هذا الشرط لضرورة بالناس فإنهم يحتاجون إلى إظهار حقوقهم بالحجة عند القاضي ولا يتمكنون من مثل هذا الخبر في كل حق يجب لبعضهم على بعض.
قلنا: رضينا بهذا الكلام ونقول: حاجتنا إلى معرفة أحكام الدين وحقوق الله تعالى علينا لنعمل به مثل حاجة من كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرته وكانوا يسمعون منه، ومعلوم أن بعد تطاول الزمان لا يوجد مثل هذا الخبر في كل حكم من أحكام الشرع، فوجب أن يجعل خبر الواحد فيه حجة للعمل باعتبار الظاهر لتحقق الحاجة إليه، كما جعل مثل هذه الحاجة معتبرا في وجوب القضاء على القاضي بالشهادة مع بقاء الاحتمال، مع أنه ليس الطريق ما قالوا في باب القضاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع الخصومة في حقوق العباد ويقضي بالشهادات والايمان، وكان يقول: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بما أسمع فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فكأنما أقطع له قطعة من النار ومعلوم أن مثل هذه الضرورة ما كان يتحقق في حقه، فقد كان الوحي ينزل عليه ولو كان توهم الكذب
في شهادة الشهود يمنع بثبوت العلم في (حق) العمل بشهادتهم لما قضى رسول الله بالشهادة قط، فإنه كان متمكنا من القضاء بعلم وذلك بأن ينتظر نزول الوحي عليه فما كان يجوز له أن يقضي بغير علم، وقد نقل قضاياه مشهورا بالشهادات والايمان فهو دليل على صحة ما قلنا.
والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في العمل بخبر الواحد أكثر من أن تحصى، وأشهر من أن تخفى، ذكر محمد رحمه الله بعضها في الاستحسان، وأورد أكثرها عيسى بن أبان رحمه الله
مستدلا بجواز العمل بخبر الواحد، ولكنا لم نشتغل بها لشهرتها، ولعلمنا أن الخصوم يتعنتون فيقولون كيف يحتجون على وجوب العمل بخبر الواحد بالآحاد من الاخبار وهو نفس الخلاف، فلهذا اشتغلنا بالاستدلال بما هو شبه المحسوس، فكأن عيسى ابن أبان إنما استدل بها لكونها مشهورة في حيز التواتر، ولان العمل بالقياس جائز فيما لا نص فيه، ثبت ذلك باتفاق الصحابة، وخبر الواحد أقوى من القياس، لان المعمول به وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شبهة فيه وإنما الشبهة في طريق الاتصال به، وفي القياس الشبهة والاحتمال في المعنى المعمول به والطريق فيهما غالب الرأي، فكان جواز العمل بالقياس دليلا على جواز العمل بخبر الواحد بالطريق الاولى.
يقرره أن العامي إذا سأل المفتي حادثته فأفتى بشئ يلزمه العمل به، ولو سأله عن اعتقاده في ذلك فأخبر أنه معتقد لما يفتيه به كان عليه أن يعتمد قوله وفيه احتمال السهو والكذب، ولكن باعتبار فقهه يترجح جانب الاصابة، وباعتبار عدالته يترجح جانب الصدق فيه فيجب العمل به، فكذلك فيما يخبر به العدل لان جانب الصدق يترجح بظهور عدالته، وما قالوا إن في هذا إثبات زيادة درجة لخبر غير المعصوم على خبر المعصوم غلط بين، فإن الحاجة إلى ظهور المعجزات لثبوت علم اليقين بنبوته، وليكون خبره موجبا علم اليقين ولا يثبت مثل ذلك بخبر مثل هذا المخبر، ألا ترى أن العمل بخبر المخبر في المعاملات جائز عدلا كان أو فاسقا إذا وقع في قلب السامع أنه صادق، ولا يكون في
هذا قولا بزيادة خبره على خبر المعصوم عن الكذب.
وأما من قال بأن خبر الواحد يوجب العلم فقد استدل بما روي أن النبي عليه السلام قال لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: ثم أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة في أموالهم ومراده الاعلام بالاخبار، وأما إذا لم يكن خبر الواحد موجبا للعلم للسامع لا يكون ذلك إعلاما، ولان العمل يجب بخبر الواحد ولا يجب العمل إلا بعلم، قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به
علم) ولان الله تعالى قال في نبأ الفاسق: (أن تصيبوا قوما بجهالة) وضد الجهالة العلم وضد الفسق العدالة، ففي هذا بيان أن العلم إنما لا يقع بخبر الفاسق وأنه يثبت بخبر العدل.
ثم قد يثبت بالآحاد من الاخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب القبر، وسؤال منكر ونكير، ورؤية الله تعالى بالابصار في الآخرة، فبهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم.
ولكنا نقول: هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين، فإن بقاء احتمال الكذب في خبر غير المعصوم معاين لا يمكن إنكاره ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الاسباب، وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الاخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر فهو المراد بقوله: (ثم أعلمهم) ويجوز العمل باعتباره كما يجوز العمل بمثله في باب القبلة عند الاشتباه، وينتفي باعتبار مطلق الجهالة لانه يترجح جانب الصدق بظهور العدالة، بخلاف خبر الفاسق فإنه يتحقق فيه المعارضة من غير أن يترجح أحد الجانبين.
فأما الآثار المروية في عذاب القبر ونحوها فبعضها مشهورة وبعضها آحاد وهي توجب عقد القلب عليه، والابتلاء بعقد القلب على الشئ بمنزلة الابتلاء بالعمل به أو أهم، فإن ذلك ليس من ضرورات العلم، قال تعالى: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) وقال تعالى: (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) فتبين أنهم تركوا عقد القلب على ثبوته بعد العلم به، وفي هذا بيان أن هذه الآثار لا تنفك عن معنى وجوب
العمل بها.
ويحكى عن النظام أن خبر الواحد عند اقتران بعض الاسباب به موجب للعلم ضرورة.
قال: ألا ترى أن من مر بباب فرأى آثار غسل الميت، وسمع عجوزا تخرج من الدار وهي تقول مات فلان، فإنه يعلم موته ضرورة بهذا الخبر، لاقتران هذا
السبب به.
قال: وهو علم يحدثه الله تعالى في قلب السامع بمنزلة العلم للسامع بخبر التواتر إذ ليس في التواتر إلا مجموع الآحاد، ويجوز القول بأن الله تعالى يحدثه في قلب بعض السامعين دون البعض كما أنه يحدث الولد ببعض الوطئ دون البعض.
وهذا قول باطل، فإن ما يكون ثابتا ضرورة لا يختلف الناس فيه، بمنزلة العلم الواقع بالمعاينة والعلم الواقع بخبر التواتر.
ثم في هذا إبطال أحكام الشرع من الرجوع إلى البينات والايمان عند تعارض الدعوة والانكار، والمصير إلى اللعان عند قذف الزوج زوجته فإن القرائن من أبين الاسباب، وكان ينبغي أن يكون خبر الزوج موجبا العلم ضرورة فلا يجوز للقاضي عند ذلك أن يصير إلى اللعان، وكذلك في سائر الخصومات ينبغي أن ينتظر إلى أن يحصل له علم الضرورة بخبر المخبرين فيعمل به، واقتران المعجزات بأخبار الرسل من أقوى الاسباب.
ثم العلم الحاصل بالنبوة يكون كسبيا لا ضروريا فكيف يستقيم مع هذا لاحد أن يقول إن بخبر الواحد يثبت العلم الضروري بحال من الاحوال.
فإن قيل: فقد قلتم الآن إن من جحد الرسالة فإنما جحد بعد العلم بها، فدل أن العلم الضروري كان ثابتا بالخبر.
قلنا: إنما كان ذلك من قوم متعنتين عرفوا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته من كتابهم ثم جحدوا عنادا، كما قال تعالى: (وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) ولا يظن أحد أن جميع الكفار كانوا عالمين بذلك ضرورة ثم تواطؤا على الجحود على ذلك، لان في هذا القول نفي العلم بخبر التواتر، فإن ثبوت العلم به باعتبار انتفاء تهمة التواطؤ فكيف يجوز إثبات علم الضروري عند خبر الواحد بطريق يدل على نفي العلم بخبر التواتر، وبمثله
يتبين عوار المبطلين، والله ولي المتقين.
فأما خبر المخبر بالموت إنما يوجب سكون النفس وطمأنينة القلب، ألا ترى أنه إذا شككه آخر بقوله اختفى صاحب الدار من
السلطان فأظهر هذا تشكك فيه، ولو كان الثابت له علما ضروريا لما تشكك فيه بخبر الواحد.
وأما من شرط عدد الشهادة استدل فيه بالنصوص الواردة في باب الشهادات، فإن الشرع اعتبر ذلك لثبوت العلم على وجه يجب العمل به، فعرفنا أن بدون ذلك لا يثبت العلم على وجه يجب العمل به في خبر متميل بين الصدق والكذب.
والدليل عليه أن أبا بكر رضي الله عنه حين شهد عنده المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام أطعم الجدة السدس قال: ائت بشاهد آخر فشهد معه محمد بن مسلمة رضي الله عنه، ولما روى أبو موسى لعمر خبر الاستئذان فقال: ائت بشاهد آخر فشهد معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم.
وقال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت.
وقال علي رضي الله عنه في حديث أبي سنان الاشجعي رضي الله عنه في مهر المثل: ماذا نصنع بقول أعرابي بوال على عقبه ! في هذا بيان أنهم كانوا لا يقبلون خبر الواحد وكانوا يعتبرون لطمأنينة القلب عدد الشهادة، كما كانوا يعتبرون لذلك صفة العدالة، ومن بالغ في الاحتياط فقد اعتبر أقصى عدد الشهادة لان ما دون ذلك محتمل، وتمام الرجحان عند انقطاع الاحتمال بحسب الامكان.
ولكنا نستدل بقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) ومعلوم أن هذا النعت لكل مؤمن، فهو تنصيص على أن قول كل مؤمن في باب الدين يكون أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وإنما يكون كذلك إذا كان يجب العمل بما يأمر به من المعروف فاشتراط العدد في الامرين يكون زيادة.
وجميع ما ذكرنا حجة على هؤلاء ولا حجة لهم في شئ مما ذكروا، فإن هذه الآثار إنما تكون حجة لهم إذا أثبتوا النقل فيها من اثنين عن اثنين حتى اتصل بهم، لان
بدون ذلك لا تقوم الحجة عندهم، ولا يتمكن أحد من إثبات هذا في شئ من أخبار الآحاد.
ثم إنما طلب أبو بكر رضي الله عنه شاهدا آخر من المغيرة لانه شك في خبره باعتبار معنى وقف عليه، أو باعتبار أنه أخبر أن هذا القضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمحضر من الجماعة فأحب أن يستثبت لذلك.
وكذلك عمر رضي الله عنه إنما أمر أبا موسى أن يأتي بشاهد آخر لانه أخبر بما تعم به البلوى فيحتاج الخاص والعام إلى معرفته فأحب أن يستثبته، ولو لم يأت بشاهد آخر لكان يقبل حديثه أيضا.
وذكر بعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله أنه لا يقبل حديثه لو لم يأت بشاهد آخر في ذلك الوقت، لان في الرواة يومئذ كثرة فكان لا تتحقق الضرورة في العمل بخبر الواحد ومثله لا يوجد بعد تطاول الزمان.
ولكن الاصح هو الاول، وعليه نص محمد رحمه الله في كتاب الاستحسان فقال: لو لم يأت بشاهد آخر لكان يقبل حديثه أيضا، ألا ترى أنه قبل حديث ضحاك بن سفيان رضي الله عنه في توريث المرأة من دية زوجها، وقبل حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الطاعون حين رجع من الشام، وقبل حديثه أيضا في أخذ الجزية من المجوس ولم يطلب منه شاهدا آخر، وإنما لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس لكونه مخالفا للكتاب والسنة فإن السكنى لها منصوص عليه في قوله: (أسكنوهن من حيث سكنتم) وهي قالت ولم يجعل لي رسول الله عليه السلام نفقة ولا سكنى، وإنما لم يقبل علي رضي الله عنه حديث أبي سنان لمذهب له كان ينفرد به وهو أنه كان لا يقبل رواية الاعراب وكان يحلف الراوي إذا روى له حديثا إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ألا ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما لم يكن هذا من مذهبه قبل حديث أبي سنان وسر به وباب الشهادات ليس نظير باب الاخبار بالاتفاق، ففي الشهادة كل امرأتين تقومان مقام رجل واحد، وفي الاخبار الرجال والنساء سواء.
ولكن نقول: اشتراط العدد في الشهادات عرفناه بالنص من غير أن يعقل فيه معنى، فإن العلم الحاصل بخبر الواحد
العدل لا يزداد بانضمام مثله إليه، وانتفاء تهمة الكذب لا يحصل أيضا بنصاب الشهادة، فعرفنا أن ذلك مما استأثر الله بعلمه والواجب علينا فيه اتباع النص، وباب
الاخبار ليس في معناه، ألا ترى أنه لا اختصاص في باب الاخبار بلفظ الشهادة ولا بمجلس القضاء، وأن الشهادات الموجبة للقضاء تختص بذلك.
وكذلك حكم الاخبار لا يختلف باختلاف المخبر به من أحكام الدين وتختلف باختلاف المشهود به، فيثبت بعض الاحكام بشهادة النساء مع الرجال ولا يثبت البعض ويثبت البعض بشهادة امرأة واحدة، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة رضي الله عنه حجة تامة.
وسنقرر هذا الكلام في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.
فصل: في بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة قال رضي الله عنه: هذه أربعة أقسام: أحدها أحكام الشرع التي هي فروع الدين فيما يحتمل النسخ والتبديل، فإنها واجبة لله تعالى علينا يلزمنا أن ندين بها.
وهي نوعان: ما لا يندرئ بالشبهات كالعبادات وغيرها، وخبر الواحد العدل حجة فيها لايجاب العمل من غير اشتراط عدد ولا لفظ بل بأوصاف تشترط في المخبر على ما نبينه، وهذا لان المعتبر فيه رجحان جانب الصدق لا انتفاء احتمال الكذب، وذلك حاصل من غير عدد ولا تعيين لفظ، وليس لزيادة العدد وتعيين اللفظ تأثير في انتفاء تهمة الكذب، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون مثل هذه الاخبار من الواحد لايجاب العمل من غير اشتراط زيادة العدد إلا على سبيل الاحتياط من بعضهم، نحو ما روي أن عليا رضي الله عنه كان يحلف الراوي على ما قال: كنت إذا لم أسمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني به غيره حلفته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: ما أذنب عبد ذنبا ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ثم استغفر ربه إلا غفر له ففي هذا بيان أنه كان يحتاط
فيحلف الراوي، وما كان يشترط زيادة العدد ولا تعيين لفظ الشهادة، فلو كان ذلك شرطا لاستوى فيه المتقدمون والمتأخرون كما في الشهادات في الاحكام.
وأما ما يندرئ بالشبهات فقد روي عن أبي يوسف رحمه الله في الامالي أن خبر الواحد فيه حجة أيضا، وهو اختيار الجصاص رحمه الله، وكان الكرخي رحمه
الله يقول: خبر الواحد فيه لا يكون حجة.
وجه القول الاول أن المعتبر في خبر الواحد ليكون حجة ترجح جانب الصدق وعند ذلك يكون العمل به واجبا فيما يندرئ بالشبهات وفيما يثبت بالشبهات كما في البينات، ولو كان مجرد الاحتمال مانعا للعمل فيما يندرئ بالشبهات لم يجز العمل فيها بالبينة.
وكذلك يجوز العمل فيها بدلالة النص مع بقاء الاحتمال.
ووجه القول الآخر أن في اتصال خبر الواحد بمن يكون قوله حجة موجبة للعلم شبهة، وما يندرئ بالشبهات لا يجوز إثباته بما فيه شبهة، ألا ترى أنه لا يجوز إثباته بالقياس، وإنما جوزنا إثباته بالشهادات بالنص وهو قوله تعالى: (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) وما كان ثابتا بالنص بخلاف القياس لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه وخبر الواحد ليس في معنى الشهادة من كل وجه.
والقسم الثاني: حقوق العباد التي فيها إلزام محض ويشترك فيها أهل الملل، وهذا لا يثبت بخبر الواحد إلا بشرط العدد، وتعيين لفظ الشهادة، والاهلية، والولاية لانها تبتنى على منازعات متحققة بين الناس بعد التعارض بين الدعوى والانكار، وإنما شرعت مرجحة لاحد الجانبين فلا يصلح نفس الخبر مرجحا للخبر إلا باعتبار زيادة توكيد من لفظ شهادة أو يمين فهما للتوكيد، ألا ترى أن كلمات اللعان شرع فيها لفظ الشهادة واليمين للتوكيد، وزيادة العدد أيضا للتوكيد، وطمأنينة القلب إلى قول المثنى أظهر، إذ الواحد يميل إلى الواحد عادة قلما يتفق الاثنان على الميل إلى الواحد
في حادثة واحدة، ولان الخصومات إنما تقع باعتبار الهمم المختلفة للناس، والمصير إلى التزوير والاشتغال بالحيل والاباطيل فيها ظاهر، فجعلها الشرع حجة بشرط زيادة العدد وتعيين لفظ الشهادة تقليلا لمعنى الحيل والتزوير فيها بحسب وسع القضاة.
وليس هذا نظير القسم الاول، فإن السامع هناك حاجته إلى الدليل للعمل به لا إلى رفع دليل مانع، وخبر الواحد باعتبار حسن الظن بالراوي دليل صالح لذلك، فأما
في المنازعات فالحاجة إلى رفع ما معه من الدليل وهو الانكار الذي هو معارض لدعوى المدعي، فاشتراط الزيادة في الخبر هنا لهذا المعنى.
ومن القسم الاول الشهادة على رؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة، فالثابت به حق الله تعالى على عباده وهو أداء الصوم.
ومن القسم الثاني الشهادة على هلال الفطر فالثابت به حق العباد لان في الفطر منفعة لهم وهو ملزم إياهم..ومن ذلك أيضا الاخبار بالحرمة بسبب الرضاع في ملك النكاح أو ملك اليمين فإنه يبتني على زوال الملك، لان ثبوت الحل لا يكون بدون الملك فانتفاؤه يوجب انتفاء الملك والملك من حقوق العباد، فإن كان الحل والحرمة من حقوق الله تعالى وكذلك الاخبار بالحرمة في الامة فإن حرمة الفرج وإن كان من حق الله تعالى فثبوتها يبتني على زوال الملك الذي هو حق العباد فلا يكون خبر الواحد حجة فيها بدون شرائط الشهادة، بخلاف الخبر بطهارة الماء ونجاسته، والخبر بحل الطعام والشراب وحرمته فإن ذلك من القسم الاول، لان ثبوت الملك ليس من ضرورة ثبوت الحل فيه، وزوال الحل لا يبتنى على زوال الملك فيه ضرورة.
ومما اختلفوا فيه التزكية، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما هي من القسم الاول لا يعتبر فيها العدد ولا لفظ الشهادة، لان الثابت بها تقرر الحجة وجواز القضاء وذلك حق الشرع وعند محمد رحمه الله هو نظير القسم الثاني في اشتراط العدد فيها، لانه يتعلق بها ما هو حق العباد وهو استحقاق القضاء
للمدعي بحقه.
والقسم الثالث: المعاملات التي تجري بين العباد مما لا يتعلق بها اللزوم أصلا، وخبر الواحد فيها حجة إذا كان المخبر مميزا عدلا كان أو غير عدل صبيا كان أو بالغا كافرا كان أو مسلما، وذلك نحو الوكالات والمضاربات والاذن للعبيد في التجارة والشراء من الوكلاء والملاك حتى إذا أخبره صبي مميز أو كافر أو فاسق أن فلانا وكله أو أن مولاه أذن له فوقع في قلبه أنه صادق يجوز له أن يشتغل بالتصرف بناء على خبره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية الطعام من البر التقي وغيره، وكان يشتري من الكافر أيضا، والمعاملات بين الناس في الاسواق من
لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ظاهر لا يخفى على واحد منهم لا يشترطون العدالة فيمن يعاملونه، وأنهم يعتمدون خبر كل مميز يخبرهم بذلك لما في اشتراط العدالة فيه من الحرج البين.
والفرق بين هذا وبين ما سبق من وجهين: أحدهما أن الضرورة (هنا) تتحقق بالحاجة إلى قبول خبر كل مميز، لان الانسان قلما يجد العدل ليبعثه إلى غلامه أو وكيله، ولا دليل مع السامع سوى هذا الخبر ولا يتمكن من الرجوع إليه للعمل، وكذلك المتصرف مع الوكيل فإن أقصى ما يمكنه أن يرجع إلى الموكل ولعله غاصب غير مالك أيضا، وللضرورة تأثير في التخفيف ولا يتحقق مثل هذه الضرورة في الاخبار فيما يرجع إلى أحكام الشرع، لان في العدول من الرواة كثرة ويتمكن السامع من الرجوع إلى دليل آخر يعمل به إذا لم يصح الخبر عنده وهو القياس الصحيح.
والثاني وهو أن هذه الاخبار غير ملزمة، لان العبد والوكيل يباح لهما الاقدام على التصرف من غير أن يلزمهما ذلك، واشتراط العدالة ليترجح جانب الصدق من الخبر، فيصلح أن يكون ملزما وذلك فيما يتعلق به اللزوم من أحكام الشرع دون ما لا يتعلق به اللزوم من المعاملات.
ثم هذه الحالة حالة
المسالمة، واشتراط زيادة العدد واللفظ في الشهادة إنما كان باعتبار المنازعة والخصومة فيسقط اعتبار ذلك عند المسالمة.
وعلى هذا بنى المسائل في آخر الاستحسان فقال: إذا قال: كان هذا العين لي في يد فلان غصبا فأخذتها منه لم يجز للسامع أن يعتمد خبره لانه في خبره يشير إلى المنازعة.
ولو قال تاب من غصبه فرده على جاز أن يعتمد خبره إذا وقع في قلبه أنه صادق لانه يشير إلى المسالمة.
وكذلك لو تزوج امرأة فأخبره مخبر بأنها حرمت عليه بسبب عارض من رضاع أو غيره يجوز له أن يعتمد خبره ويتزوج أختها.
ولو أخبره أنها كانت محرمة عليه عند العقد لم يقبل خبره لانه ليس في الحرمة الطارئة معنى المنازعة، وفي المقارنة للعقد يتحقق ذلك، فإقدامه على مباشرة العقد تصريح منه بأنها حلال له.
وكذلك المرأة إذا أخبرت بأن الزوج طلقها وهو غائب يجوز لها أن تعتمد خبر المخبر وتتزوج بعد انقضاء العدة، بخلاف ما إذا أخبرت أن العقد كان بينهما باطلا في الاصل بمعنى من المعاني.
والمسائل على هذا الاصل كثيرة.
والقسم الرابع: ما يتعلق به اللزوم من وجه دون وجه من المعاملات، وذلك نحو الحجر على العبد المأذون وعزل الوكيل فإن الحجر نظير الاطلاق، فمن هذا الوجه هو غير ملزم إياه شيئا، ولكنه لو تصرف بعد ثبوت الحجر كان ذلك ملزما إياه العهدة، ففي هذا الخبر معنى اللزوم من هذا الوجه.
ثم على قول أبي حنيفة رضي الله عنه يشترط في هذا الخبر أحد شرطي الشهادة إما العدد أو العدالة، وعند أبي يوسف ومحمد هذا نظير ما سبق، والشرط فيه أن يكون المخبر مميزا عدلا كان أو غير عدل، حتى إذا أخبر فاسق العبد بأن مولاه قد حجر عليه يصير محجورا عندهما اعتبارا للحجر بالاطلاق، فالمعنى الذي ذكرنا فيه موجود هنا، وقياسا للمخبر الفضولي على ما إذا كان رسول المولى.
وكذلك إذا أخبر الوكيل بأن الموكل عزله أو أخبرت البكر بأن وليها زوجها فسكتت أو أخبر الشفيع ببيع الدار فسكت عن طلب
الشفعة أو أخبر المولى بأن عبده جنى فأعتقه، فأبو حنيفة يقول في هذه الفصول كلها خبر الفاسق غير معتبر إذا نشأ الخبر من عنده لان فيه معنى اللزوم فإنه يلزمه الكف عن التصرف إذا أخبره بالحجر والعزل، ويلزمها النكاح إذا سكتت بعد العلم، والكف عن طلب الشفعة إذا سكت بعد العلم، والدية إذا أعتق بعد العلم بالجناية.
وخبر الفاسق لا يكون ملزما لان التوقف في خبر الفاسق ثابت بالنص ومن ضرورته أن لا يكون ملزما، بخلاف الرسول فإن عبارته كعبارة المرسل، ثم بالمرسل حاجة إلى تبليغ ذلك وقلما يجد عدلا يستعمله في الارسال إلى عبده ووكيله.
فأما الفضولي فمتكلف لا حاجة به إلى هذا التبليغ والسامع غير محتاج إليه أيضا لانه معه دليل يعتمده للتصرف إلى أن يبلغه ما يرفعه، فلهذا شرطنا العدالة في الخبر في هذا القسم، ولا يشترط العدد لان اشتراطها لاجل منازعة متحققة وذلك غير موجود هنا، فإن كان المخبر هنا فاسقين فقد قال بعضهم يثبت بخبرهما لوجود أحد الشرطين.
وقال بعضهم لا يثبت لان خبر الفاسقين لا يصلح للالزام
كخبر الفاسق الواحد.
ولفظ الكتاب مشتبه فإنه قال حتى يخبره رجلان أو رجل عدل فقيل: معناه: رجلان عدل أو رجل عدل لان صيغة هذا النعت للفرد والجماعة واحد، ألا ترى أنه يقال: شاهدا عدل.
ومن اعتمد القول الاول قال اشتراط زيادة العدد للتوكيد هنا بمنزلة اشتراط العدد في إخبار العدول في الشهادات فإنها للتوكيد، واستدل عليه بما قال في الاستحسان: لو أخبر أحد المخبرين بطهارة الماء والآخر بنجاسته وأحدهما عدل والآخر غير عدل، فإنه يعتمد خبر العدل منهما.
ولو كان في أحد الجانبين مخبران وفي الجانب الآخر واحد واستووا في صفة العدالة فإنه يأخذ بقول الاثنين.
وكذلك في الجرح والتعديل كما يرجح خبر العدل على خبر غير العدل يترجح خبر المثنى من العدول على خبر الواحد، فعرفنا أن في زيادة العدد معنى
التوكيد.
والذي أسلم في دار الحرب إذا لم يعلم بوجوب العبادات عليه حتى مضى زمان لم يلزمه القضاء، فإن أخبره بذلك فاسق فقد قال مشايخنا هو على الخلاف أيضا: عند أبي حنيفة لا يعتبر هذا الخبر في إيجاب القضاء عليه، وعندهما يعتبر.
قال رضي الله عنه: والاصح عندي أنه يعتبر الخبر هنا في إيجاب القضاء عندهم جميعا لان هذا المخبر نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور من جهته بالتبليغ كما قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب فهو بمنزلة رسول المالك إلى عبده، ثم هو غير متكلف في هذا الخبر ولكنه مسقط عن نفسه ما لزمه من الامر بالمعروف فلهذا يعتبر خبره.
فصل: في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة قال رضي الله عنه: اعلم بأن الرواة قسمان: معروف، ومجهول.
فالمعروف نوعان: من كان معروفا بالفقه والرأي في الاجتهاد، ومن كان معروفا بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقه.
فالنوع الاول كالخلفاء الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي موسى الاشعري وعائشة وغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة رضي الله عنهم، وخبرهم حجة موجبة
للعلم الذي هو غالب الرأي، ويبتنى عليه وجوب العمل، سواء كان الخبر موافقا للقياس أو مخالفا له، فإن كان موافقا للقياس تأيد به، وإن كان مخالفا للقياس يترك القياس ويعمل بالخبر.
وكان مالك بن أنس يقول يقدم القياس على خبر الواحد في العمل به، لان القياس حجة بإجماع السلف من الصحابة، ودليل الكتاب والسنة والاجماع أقوى من خبر الواحد فكذلك ما يكون ثابتا بالاجماع.
ولكنا نقول: ترك القياس بالخبر الواحد في العمل به أمر مشهور في الصحابة ومن بعدهم من السلف لا يمكن إنكاره حتى يسمون ذلك معدولا به عن القياس، وعليه دل حديث عمر رضي الله
عنه فإن حمل ابن مالك رضي الله عنه حين روى له حديث الغرة في الجنين قال: كدنا أن نقضي فيه برأينا فيما فيه قضاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به.
وفي رواية: لولا ما رويت لرأينا خلاف ذلك.
وقال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي عليه السلام نهى عن إكراء المزارع فتركناه لاجل قوله، ولان قول الرسول صلى الله عليه وسلم موجب للعلم باعتبار أصله وإنما الشبهة في النقل عنه.
فأما الوصف الذي به القياس فالشبهة والاحتمال في أصله لانا لا نعلم يقينا أن ثبوت الحكم المنصوص باعتبار هذا الوصف من بين سائر الاوصاف، وما يكون الشبهة في أصله دون ما تكون الشبهة في طريقه بعد التيقن بأصله، يوضحه أن الشبهة هنا باعتبار توهم الغلط والنسيان في الراوي وذلك عارض، وهناك باعتبار التردد بين هذا الوصف وسائر الاوصاف وهو أصل، ثم الوصف الذي هو معنى من المنصوص كالخبر والرأي، والنظر فيه كالسماع، والقياس كالعمل به، ولا شك أن الوصف ساكت عن البيان والخبر بيان في نفسه فيكون الخبر أقوى من الوصف في الابانة، والسماع أقوى من الرأي في الاصابة، ولا يجوز ترك القوي بالضعيف.
فأما المعروف بالعدالة والضبط والحفظ كأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما وغيرهما ممن اشتهر بالصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسماع منه مدة
طويلة في الحضر والسفر، فإن أبا هريرة ممن لا يشك أحد في عدالته وطول صحبته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له: (زر غبا تزدد حبا) وكذلك في حسن حفظه وضبطه، فقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك على ما روي عنه أنه قال: يزعمون أن أبا هريرة يكثر الرواية وإني كنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني والانصار يشتغلون بالقيام على أموالهم والمهاجرون بتجاراتهم،
فكنت أحضر إذا غابوا، وقد حضرت مجلسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (من يبسط منكم رداءه حتى أفيض فيه مقالتي فيضمها إليه ثم لا ينساها) فبسطت بردة كانت علي فأفاض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته ثم ضممتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك شيئا.
ولكن مع هذا قد اشتهر من الصحابة رضي الله عنه ومن بعدهم معارضة بعض رواياته بالقياس، هذا ابن عباس رضي الله عنهما لما سمعه يروي: (توضؤوا مما مسته النار) قال: أرأيت لو توضأت بماء سخن أكنت تتوضأ منه، أرأيت لو ادهن أهلك بدهن فادهنت به شاربك أكنت تتوضأ منه ! فقد رد خبره بالقياس، حتى روي أن أبا هريرة قال (له): يا ابن أخي إذا أتاك الحديث فلا تضرب له الامثال.
ولا يقال إنما رده باعتبار نص آخر عنده، وهو ما روي أن النبي عليه السلام أتى بكتف مؤربة فأكلها وصلى ولم يتوضأ، لانه لو كان عنده نص لما تكلم بالقياس ولا أعرض عن أقوى الحجتين، أو كان سبيله أن يطلب التاريخ بينهما ليعرف الناسخ من المنسوخ، أو أن يخصص اللحم من ذلك الخبر بهذا الحديث، فحيث اشتغل بالقياس وهو معروف بالفقه والرأي من بين الصحابة على وجه لا يبلغ درجة أبي هريرة في الفقه ودرجته، عرفنا أنه استخار التأمل في روايته إذا كان مخالفا للقياس.
ولما سمعه يروي: من حمل جنازة فليتوضأ قال أيلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة ؟ ! ولما سمعت عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة يروي أن ولد الزنا شر الثلاثة.
قالت: كيف يصح هذا وقد قال الله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)
وهذا عام دخله خصوص.
وروي أن عائشة قالت لابن أخيها ألا تعجب من كثرة رواية هذا الرجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بأحاديث لو عدها عاد لاحصاها ! وقال إبراهيم النخعي رضي الله عنه: كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون.
وقال لو كان ولد الزنا شر الثلاثة لما انتظر بأمه أن تضع.
وهذا نوع قياس.
ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن أبا هريرة يروي ما لا يعرف قال: لتكفن عن هذا أو لالحقنك بجبال دوس.
فلمكان ما اشتهر من السلف في هذا الباب قلنا ما وافق القياس من روايته فهو معمول به، وما خالف القياس فإن تلقته الامة بالقبول فهو معمول به، وإلا فالقياس الصحيح شرعا مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه.
ولعل ظانا يظن أن في مقالتنا ازدراء به ومعاذ الله من ذلك، فهو مقدم في العدالة والحفظ والضبط كما قررنا، ولكن نقل الخبر بالمعنى كان مستفيضا فيهم، والوقوف على كل معنى أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه أمر عظيم، فقد أوتي جوامع الكلم على ما قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي اختصارا ومعلوم أن الناقل بالمعنى لا ينقل إلا بقدر ما فهمه من العبارة، وعند قصور فهم السامع ربما يذهب عليه بعض المراد، وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة بما هو فقه (لفظ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلتوهم هذا القصور قلنا: إذا انسد باب الرأي فيما روي وتحققت الضرورة بكونه مخالفا للقياس الصحيح فلا بد من تركه، لان كون القياس الصحيح حجة ثابت بالكتاب والسنة والاجماع فما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو في المعنى مخالف للكتاب والسنة المشهورة والاجماع.
وبيان هذا في حديث المصراة فإن الامر برد صاع من تمر مكان اللبن قل أو كثر مخالف للقياس الصحيح من كل وجه، لان تقدير الضمان في العدوانات بالمثل أو القيمة حكم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع.
وكذلك فيما يرويه سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال فيمن وطئ جارية امرأته: فإن طاوعته فهي له وعليه مثلها، وإن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها فإن القياس الصحيح يرد هذا الحديث ويتبين أنه كالمخالف للكتاب والسنة المشهورة والاجماع.
ثم هذا النوع من القصور لا يتوهم في الراوي إذا كان فقيها لان ذلك لا يخفى عليه لقوة فقهه، فالظاهر أنه إنما روى الحديث بالمعنى
عن بصيرة فإنه علم سماعه (من رسول الله كذلك مخالفا للقياس ولا تهمة في روايته فكأنا سمعنا ذلك) من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلزمنا ترك كل قياس بمقابلته، ولهذا قلت رواية الكبار من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، ألا ترى إلى ما روي عن عمرو بن ميمون قال: صحبت ابن مسعود سنين فما سمعته يروي حديثا إلا مرة واحدة، فإنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذه البهر والفرق وجعلت فرائصه ترتعد فقال نحو هذا أو قريبا منه أو كلاما هذا معناه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا.
فبهذا يتبين أن الوقوف على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاني كلامه كان عظيما عندهم فلهذا قلت رواية الفقهاء منهم، فإذا صحت الرواية عنهم فهو مقدم على القياس.
ومع هذا كله فالكبار من أصحابنا يعظمون رواية هذا النوع منهم ويعتمدون قولهم، فإن محمدا رحمه الله ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أخذ بقول أنس بن مالك رضي الله عنه في مقدار الحيض وغيره وكان درجة أبي هريرة فوق درجته، فعرفنا بهذا أنهم ما تركوا العمل بروايتهم إلا عند الضرورة لانسداد باب الرأي من الوجه الذي قررنا.
فأما المجهول فإنما نعني بهذا اللفظ من لم يشتهر بطول الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عرف بما روي من حديث أو حديثين، نحو وابصة بن معبد، وسلمة بن المحبق، ومعقل بن سنان الاشجعي رضي الله عنهم وغيرهم.
ورواية هذا النوع على خمسة أوجه: أحدها أن يشتهر لقبول الفقهاء روايته والرواية عنه، والثاني أن يسكتوا عن الطعن فيه بعدما يشتهر، والثالث أن يختلفوا في الطعن في روايته، والرابع أن يطعنوا في روايته من غير خلاف بينهم في ذلك، والخامس أن لا تظهر روايته ولا الطعن فيه فيما بينهم.
أما من قبل السلف منه روايته وجوزوا النقل عنه
فهو بمنزلة المشهورين في الرواية: لانهم ما كانوا متهمين بالتقصير في أمر الدين،
وما كانوا يقبلون الحديث حتى يصح عندهم أنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإما أن يكون قبولهم لعلمهم بعدالته وحسن ضبطه، أو لانه موافق لما عندهم مما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعض المشهورين يروي عنه.
وكذلك إن سكتوا عن الرد بعدما اشتهر روايته عندهم، لان السكوت بعد تحقق الحاجة لا يحل إلا على وجه الرضا بالمسموع فكان سكوتهم عن الرد دليل التقرير، بمنزلة ما لو قبلوه وردوا عنه.
وكذلك ما اختلفوا في قبوله وروايته عنه عندنا، لانه حين قبله بعض الفقهاء المشهورين منهم فكأنه روى ذلك بنفسه.
وبيان هذا في حديث معقل بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واشق الاشجعية بمهر مثلها حين مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقا، فإن ابن مسعود رضي الله عنه قبل روايته وسر به لما وافق قضاءه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلي رضي الله عنه رده فقال: ماذا نصنع بقول أعرابي بوال على عقبه حسبها الميراث لا مهر لها.
فلما اختلفوا فيه في الصدر الاول أخذنا بروايته، لان الفقهاء من القرن الثاني كعلقمة ومسروق والحسن ونافع بن جبير قبلوا روايته فصار معدلا بقبول الفقهاء روايته.
وكذلك أبو الجراح صاحب راية الاشجعيين صدقه في هذه الرواية.
وكأن عليا رضي الله عنه إنما لم يقبل روايته لانه كان مخالفا للقياس عنده، وابن مسعود رضي الله عنه قبل روايته لانه كان موافقا للقياس عنده.
فتبين بهذا أن رواية مثل هذا فيما يوافق القياس يكون مقبولا ثم العمل يكون بالرواية.
وأما إذا ردوا عليه روايته ولم يختلفوا في ذلك فإنه لا يجوز العمل بروايته، لانهم كانوا لا يتهمون برد الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بترك العمل به وترجيح الرأي بخلافه عليه، فاتفاقهم على الرد دليل على أنهم كذبوه في هذه الرواية وعلموا أن ذلك وهم منه.
ولو قال الراوي أوهمت لم يعمل بروايته، فإذا ظهر دليل ذلك ممن هو فوقه أولى.
وبيان هذا في حديث فاطمة بنت قيس، فإن عمر رضي الله عنه قال: لا ندع
كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت.
قال عيسى
بن أبان رحمه الله مراده من الكتاب والسنة القياس الصحيح، فإن ثبوته بالكتاب والسنة وهو قياس الشبه في اعتبار النفقة بالسكنى من حيث إن كل واحد منهما حق مالي مستحق بالنكاح.
فإن قيل: هذا إشارة إلى غير ما أشار إليه عمر، فإنه لم يقل لا نقبل حديثها لعلمنا أنها أوهمت، ولكن قال: لا ندع كتاب ربنا لانا لا ندري أصدقت أم كذبت.
قلنا: في قوله لا ندري إشارة إلى هذا المعنى، فإن قبول الرواية والعمل به يبتني على ظهور رجحان جانب الصدق وهو بين أنه لم يظهر رجحان جانب الصدق في روايتها، والرأي يدل على خلاف روايتها فنترك روايتها ونعمل بالقياس الصحيح، وفي المعنى لا فرق بين هذا وبين قوله لا نقبل روايتها، بمنزلة القاضي يرد شهادة الفاسق بقوله ائت بشاهد آخر ائت بحجة.
ومن هذا النحو حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه في القسامة: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ وحديث بسرة رضي الله عنها: من مس ذكره فليتوضأ وحديث أبي هريرة: من أصبح جنبا فلا صوم له وأما ما لم يشتهر عندهم ولم يعارضوه بالرد فإن العمل به لا يجب ولكن يجوز العمل به إذا وافق القياس، لان من كل من الصدر الاول فالعدالة ثابتة له باعتبار الظاهر، لانه في زمان الغالب من أهله العدول على ما قال عليه السلام: خير الناس قرني الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم فباعتبار الظاهر يترجح جانب الصدق في خبره، وباعتبار أنه لم تشتهر روايته في السلف يتمكن تهمة الوهم فيه فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به ولكن لا يجب العمل به، لان الوجوب شرعا لا يثبت بمثل هذا الطريق الضعيف، ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستور، ولم يوجب على القاضي القضاء، لانه
كان في القرن الثالث والغالب على أهله الصدق، فأما في زماننا رواية مثل هذا لا يكون مقبولا، ولا يصح العمل به ما لم يتأيد بقبول العدول روايته، لان الفسق
غلب على أهل هذا الزمان، ولهذا لم يجوز أبو يوسف ومحمد القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالته.
فصار الحاصل أن الحكم في رواية المشهور الذي لم يعرف بالفقه وجوب العمل وحمل روايته على الصدق إلا أن يمنع منه مانع وهو أن يكون مخالفا للقياس وأن الحكم في رواية المجهول أنه لا يكون حجة للعمل إلا أن يتأيد بمؤيد وهو قبول السلف أو بعضهم روايته، والله أعلم.
فصل: في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما قال رضي الله عنه: اعلم بأن هذه الشرائط أربعة: العقل، والضبط، والعدالة، والاسلام.
أما اشتراط العقل: فلان الخبر الذي يرويه كلام منظوم له معنى معلوم، ولا بد من اشتراط العقل في المتكلم من العباد ليكون قوله كلاما معتبرا، فالكلام المعتبر شرعا ما يكون عن تمييز وبيان، لا عن تلقين وهذيان، ألا ترى أن من الطيور من يسمع منه حروف منظومة ويسمى ذلك لحنا لا كلاما، وكذلك إذا سمع من إنسان صوته بحروف منظومة لا يدل على معنى معلوم لا يسمى ذلك كلاما، فعرفنا أن معنى الكلام في الشاهد ما يكون مميزا بين أسماء الاعلام، فما لا يكون بهذه الصفة يكون كلاما صورة لا معنى، بمنزلة ما لو صنع من خشب صورة آدمي لا يكون آدميا لانعدام معنى الآدمي فيه.
ثم التمييز الذي به يتم الكلام بصورته ومعناه لا يكون إلا بعد وجود العقل، فكان العقل شرطا في المخبر، لان خبره أحد أنواع الكلام فلا يكون معتبرا إلا باعتبار عقله.
وأما الضبط: فلان قبول الخبر باعتبار معنى الصدق فيه ولا يتحقق ذلك
إلا بحسن ضبط الراوي من حين يسمع إلى حين يروي.
فكان الضبط لما هو معنى هذا النوع من الكلام بمنزلة العقل الذي به يصح أصل الكلام شرعا.
وأما العدالة: فلان الكلام في خبر من هو غير معصوم عن الكذب فلا تكون جهة الصدق متعينا في خبره لعينه، وإنما يترجح جانب الصدق بظهور عدالته، لان
الكذب محظور عقله فنستدل بانزجاره عن سائر ما نعتقده محظورا على انزجاره عن الكذب الذي نعتقده محظورا، أو لما كان منزجرا عن الكذب في أمور الدنيا فذلك دليل انزجاره عن الكذب في أمور الدين وأحكام الشرع بالطريق الاولى، فأما إذا لم يكن عدلا في تعاطيه فاعتبار جانب تعاطيه يرجح معنى الكذب في خبره، لانه لما لم يبال من ارتكاب سائر المحظورات مع اعتقاده حرمته، فالظاهر أنه لا يبالي من الكذب مع اعتقاده حرمته، واعتبار جانب اعتقاده يدل على الصدق في خبره فتقع المعارضة ويجب التوقف، وإذا كان ترجيح جانب الصدق باعتبار عدالته وبه يصير الخبر حجة للعمل شرعا، فعرفنا أن العدالة في الراوي شرط لكون خبره حجة.
فأما اشتراط الاسلام: لانتفاء تهمة الكذب لا باعتبار نقصان حال المخبر بل باعتبار زيادة شئ فيه يدل على كذبه في خبره، وذلك لان الكلام في الاخبار التي يثبت بها أحكام الشرع، وهم يعادوننا في أصل الدين بغير حق على وجه هو نهاية في العداوة فيحملهم ذلك على السعي في هدم أركان الدين بإدخال ما ليس منه فيه، وإليه أشار الله تعالى في قوله: (لا يألونكم خبالا) أي لا يقصرون في الافساد عليكم، وقد ظهر منهم هذا بطريق الكتمان، فإنهم كتموا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته من كتابه بعدما أخذ عليهم الميثاق بإظهار ذلك فلا يؤمنون من أن يقصدوا مثل ذلك بزيادة هي كذب لا أصل له بطريق الرواية، بل هذا هو الظاهر، فلاجل هذا شرطنا الاسلام في الراوي لكون خبره
حجة، ولهذا لم تجوز شهادتهم على المسلمين، لان العداوة ربما تحملهم على القصد للاضرار بالمسلمين بشهادة الزور، كما لا تقبل شهادة ذي الضغن لظهور عداوته بسبب الباطن، وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانعدام هذا المعنى الباعث على الكذب فيما بينهم.
وبهذا تبين أن رد خبره ليس لعين الكفر بل لمعنى زائد يمكن تهمة الكذب في خبره، بمنزلة شهادة الاب للولد فإنها لا تكون مقبولة لمعنى زائد يمكن تهمة الكذب في شهادته وهو شفقة الابوة وميله إلى ولده طبعا.
وأما بيان حد هذه الشروط وتفسيرها فنقول: العقل نور في الصدر به يبصر
القلب عند النظر في الحجج بمنزلة السراج، فإنه نور تبصر العين به عند النظر فترى ما يدرك بالحواس لا أن السراج يوجب رؤية ذلك ولكنه يدل العين عند النظر عليه، فكذلك نور الصدر الذي هو العقل يدل القلب على معرفة ما هو غائب عن الحواس من غير أن يكون موجبا لذلك، بل القلب يدرك (بالعقل) ذلك بتوفيق الله تعالى، وهو في الحاصل عبارة عن الاختيار الذي يبتنى عليه المرء ما يأتي به وما يذر مما لا ينتهي إلى إدراكه سائر الحواس، فإن الفعل أو الترك لا يعتبر إلا لحكمة وعاقبة حميدة، ولهذا لا يعتبر من البهائم لخلوه عن هذا المعنى، والعاقبة الحميدة لا تتحقق فيما يأتي به الانسان من فعل أو ترك له إلا بعد التأمل فيه بعقله، فمتى ظهرت أفعاله على سنن أفعال العقلاء كان ذلك دليلا لنا على أنه عاقل مميز وأن فعله وقوله ليس يخلو عن حكمة وعاقبة حميدة، وهذا لان العقل لا يكون موجودا في الآدمي باعتبار أصله ولكنه خلق من خلق الله تعالى يحدث شيئا فشيئا، ثم يتعذر الوقوف على وجود كل جزء منه بحسب ما يمضي من الزمان على الصبي إلى أن يبلغ صفة الكمال، فجعل الشرع الحد لمعرفة كمال العقل هو البلوغ تيسيرا للامر علينا، لان اعتدال الحال عند ذلك يكون عادة والله تعالى هو العالم حقيقة بما يحدثه من ذلك
في كل أحد من عباده من نقصان أو كمال، ولكن لا طريق لنا إلى الوقوف على حد ذلك، فقام السبب الظاهر في حقنا مقام المطلوب حقيقة تيسيرا، وهو البلوغ مع انعدام الآفة، ثم يسقط اعتبار ما يوجد من العقل للصبي قبل هذا الحد شرعا لدفع الضرر عنه لا للاضرار به، فإن الصبا سبب للنظر له، ولهذا لم يعتبر فيما يتردد بين المنفعة والمضرة ويعتبر فيما يتمخض منفعة له.
ثم خبره في أحكام الشرع لا يكون حجة للالزام دفعا لضرر العهدة عنه، كما لا يجعل وليا في تصرفاته في أمور الدنيا دفعا لضرر العهدة عنه، ولهذا صح سماعه وتحمله للشهادة قبل البلوغ إذا كان مميزا، فقد كان في الصحابة من سمع في حالة الصغر وروى بعد البلوغ وكانت روايته مقبولة، لانه ليس في ذلك من معنى ضرر لزوم العهدة شئ، وإنما يكون ذلك في الاداء فيشترط لفسخه أدائه على وجه يكون حجة كونه عاقلا مطلقا.
ولا يحصل ذلك إلا
باعتدال حاله ظاهرا كما بينا.
وصار الحاصل أن العاقل نوعان: من يصيب بعض العقل على وجه يتمكن من التمييز به بين ما يضره وما ينفعه ولكنه ناقص في نفسه كالصبي قبل البلوغ والمعتوه الذي يعقل، وعاقل هو كامل العقل وهو البالغ الذي لا آفة به، فإن بالآفة يستدل تارة على انعدام العقل بعد البلوغ كالمجنون، وتارة على نقصان العقل كما في حق المعتوه، فإذا انعدمت الآفة كان اعتدال الظاهر بالبلوغ دليلا على كمال العقل الذي هو الباطن، والمطلق من كل شئ يتناول الكامل منه، فاشتراط العقل لصحة خبره على وجه يكون حجة دليل على أنه يشترط كمال العقل في ذلك.
فأما الضبط: فهو عبارة عن الاخذ بالجزم، وتمامه في الاخبار أن يسمع حق السماع، ثم يفهم المعنى الذي أريد به، ثم يحفظ ذلك (بجهده، ثم يثبت على ذلك) بمحافظة حدوده ومراعاة حقوقه بتكراره إلى أن يؤدي إلى غيره، لان بدون السماع لا يتصور الفهم، وبعد السماع إذا لم يفهم معنى الكلام لم يكن ذلك سماعا مطلقا بل
يكون ذلك سماع صوت لا سماع كلام هو خبر، وبعد فهم المعنى يتم التحمل وذلك يلزمه الاداء كما تحمل، ولا يتأتى ذلك إلا بحفظه والثبات على ذلك إلى أن يؤدي.
ثم الاداء إنما يكون مقبولا منه باعتبار معنى الصدق فيه وذلك لا يتأتى إلا بهذا، ولهذا لم يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه أداء الشهادة لمن عرف خطه في الصك ولا يتذكر الحادثة لانه غير ضابط لما تحمل وبدون الضبط لا يجوز له أداء الشهادة.
ثم الضبط نوعان: ظاهر، وباطن.
فالظاهر منه بمعرفة صيغة المسموع والوقوف على معناه لغة، والباطن منه بالوقوف على معنى الصيغة فيما يبتنى عليه أحكام الشرع وهو الفقه، وذلك لا يتأتى إلا بالتجربة والتأمل بعد معرفة معاني اللغة وأصول أحكام الشرع، ولهذا لم تقبل رواية من اشتدت غفلته إما خلقة أو مسامحة ومجازفة، لان الضبط ظاهرا لا يتم منه عادة، وما يكون شرطا يراعي وجوده بصفة الكمال، ولهذا لم يثبت السلف المعارضة بين رواية من لم يعرف بالفقه ورواية من عرف بالفقه لانعدام الضبط باطنا ممن لم يعرف بالفقه، على ما يروى عن عمرو بن دينار أن جابر بن زيد أبا الشعثاء، روى له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
تزوج ميمونة وهو محرم، قال عمرو فقلت لجابر: إن ابن شهاب أخبرني عن يزيد بن الاصم أن النبي عليه السلام تزوجها وهو حلال.
فقال: إنها كانت خالة ابن عباس وهو أعلم بحالها.
فقلت: وقد كانت خالة يزيد بن الاصم أيضا.
فقال: أنى يجعل يزيد بن الاصم بوال على عقبه إلى ابن عباس ! فدل أن رواية غير الفقيه لا تكون معارضة لرواية الفقيه، وهذا الترجيح ليس إلا باعتبار تمام الضبط من الفقيه، وكأن المعنى فيه أن نقل الخبر بالمعنى كان مشهورا فيهم، فمن لا يكون معروفا بالفقه ربما يقصر في أداء المعنى بلفظه بناء على فهمه، ويؤمن مثل ذلك من الفقيه، ولهذا قلنا إن المحافظة على اللفظ في زماننا أولى من الرواية بالمعنى لتفاوت ظاهر بين
الناس في فهم المعنى.
فإن قيل: كيف يستقيم هذا ونقل القرآن صحيح ممن لا يفهم معناه ؟ قلنا: أصل النقل في القرآن من أئمة الهدى الذين كانوا خير الورى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما نقلوا بعد تمام الضبط، ثم من بعدهم إنما ينقل بعد جهد شديد يكون منه في التعلم والحفظ واستدامة القراءة، ولو وجد مثل ذلك في الخبر لكنا نجوز نقله أيضا، مع أن الله تعالى وعد حفظ القرآن عن تحريف المبطلين بقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وبهذا النص عرفنا انقطاع طمع الملحدين عن القرآن فصححنا النقل فيه ممن يكون ضابطا له ظاهرا وإن كان لا يعرف معناه، ومثل ذلك لا يوجد في الاخبار فكان تمام الضبط فيها بما قلنا.
مع أن هناك يتعلق بالنظم أحكام: منها حرمة القراءة على الجنب والحائض، وجواز الصلاة بها في قول بعض العلماء، وكون النظم معجزا.
فأما في الاخبار المعتبر هو المعنى المراد بالكلام، فتمام الضبط إنما يكون بالوقوف على ما هو المراد، ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا تجوز الشهادة على الكتاب والختم إذا لم يعرف الشاهد ما في باطن الكتاب، لان الضبط في الشهادة شرط للاداء
والمقصود ما في باطن الكتاب لا عين الكتاب فلا يتم ضبطه إلا بمعرفة ذلك، ولهذا استحب المتقدمون من السلف تقليل الرواية، ومن كان أكرمهم وأدوم صحبة وهو الصديق رضي الله عنه كان أقلهم رواية، حتى روي عنه أنه قال: إذا سئلتم عن شئ فلا ترووا ولكن ردوا الناس إلى كتاب الله تعالى.
وقال عمر رضي الله عنه: أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم.
ولما قيل ل زيد بن أرقم ألا تروي لنا عن رسول الله عليه السلام شيئا فقال: قد كبرنا ونسينا والرواية عن رسول الله شديد.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات ! فقد جمع أهل الحديث في هذا الباب آثارا كثيرة ولاجلها قلت رواية أبي حنيفة رضي الله عنه حتى قال بعض الطاعنين إنه كان لا يعرف الحديث.
ولم يكن على ما ظن، بل كان أعلم أهل عصره بالحديث، ولكن لمراعاة شرط كمال الضبط قلت روايته.
وبيان هذا أن الانسان قد ينتهي إلى مجلس وقد مضى صدر من الكلام فيخفي على المتكلم حاله لتوقفه على ما مضى من كلامه مما يكون بعده بناء عليه، فقلما يتم ضبط هذا السامع لمعنى ما يسمع بعد ما فاته أول الكلام، ولا يجد في تأمل ذلك أيضا، لانه لا يرى نفسه أهلا بأن يؤخذ الدين عنه، ثم يكون من قضاء الله تعالى أن يصير صدرا يرجع إليه في معرفة أحكام الدين، فإذا لم يتم ضبطه في الابتداء لم ينبغ له أن يجازف في الرواية، وإنما ينبغي أن يشتغل بما وجد منه الجهد التام في ضبطه فيستدل بكثرة الرواية ممن كان حاله في الابتداء بهذه الصفة على قلة المبالاة، ولهذا ذم السلف الصالح كثرة الرواية، وهذا معنى معتبر في الروايات والشهادات جميعا، ألا ترى أن من اشتهر في الناس بخصلة دالة على قلة المبالاة من قضاء الحاجة بمرأى العين من الناس أو الاكل في الاسواق يتوقف في شهادته.
فهذا بيان تفسير الضبط.
وأما العدالة: فهي الاستقامة.
يقال: فلان عادل إذا كان مستقيم السيرة في الانصاف والحكم بالحق.
وطريق عادل، سمي به الجادة، وضده الجور.
ومنه يقال: طريق جائر إذا كان من البنيات.
ثم العدالة نوعان: ظاهرة، وباطنة.
فالظاهرة
تثبت بالدين والعقل على معنى أن من أصابها فهو عدل ظاهرا، لانهما يحملانه على الاستقامة ويدعوانه إلى ذلك.
والباطنة لا تعرف إلا بالنظر في معاملات المرء، ولا يمكن الوقوف على نهاية ذلك لتفاوت بين الناس فيهما، ولكن كل من كان ممتنعا من ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه فهو على طريق الاستقامة في حدود الدين.
وعلى هذه العدالة نبني حكم رواية الخبر في كونه حجة، لان ما تثبت به العدالة الظاهرة بعارضة هوى النفس والشهوة الذي تصده عن الثبات على طريق الاستقامة، فإن الهوى أصل فيه سابق على إصابة العقل، ولا يزايله بعدما رزق العقل، وبعدما اجتمعا فيه يكون عدلا من وجه دون وجه، فيكون حاله كحال الصبي العاقل والمعتوه الذي يعقل من جملة العقلاء، وقد بينا أن المطلق يقتضي الكامل، فعرفنا أن العدل مطلقا من يترجح أمر دينه على هواه، ويكون ممتنعا بقوة الدين عما يعتقد الحرمة فيه من الشهوات، ولهذا قال في كتاب الشهادات: إن من ارتكب كبيرة فإنه لا يكون عدلا في الشهادة، وفيما دون الكبيرة من المعاصي إن أصر على ارتكاب شئ لم يكن مقبول الشهادة.
وكان ينبغي أن لا يكون مقبول الشهادة أصر أو لم يصر، لانه فاسق بخروجه عن الحد المحدود له شرعا، والفاسق لا يكون عدلا في الشهادة، إلا أن في القول بهذا سد الباب أصلا فغير المعصوم لا يتحقق منه التحرز عن الزلات أجمع، لان لله تعالى على العباد في كل لحظة أمرا ونهيا يتعذر عليهم القيام بحقهما، ولكن التحرز عن الاصرار بالندم والرجوع عنه غير متعذر، والحرج مدفوع، وليس في التحرز عن ارتكاب الكبائر الموجبة للحد معنى الحرج، فلهذا بنينا حكم العدالة على التحرز المتأتي عما يعتقد الحرمة فيه، ولهذا قلنا صاحب الهوى إذا كان ممتنعا عما يعتقد الحرمة فيه فهو مقبول الشهادة وإن كان فاسقا في اعتقاده ضالا، لانه بسبب الغلو في طلب الحجة والتعمق في اتباعه أخطأ الطريق فضل عن سواء السبيل، وشدة اتباع الحجة لا تمكن تهمة الكذب في شهادته وإن أخطأ الطريق، وكذلك الكافر من أهل الشهادة إذا كان عدلا في تعاطيه بأن كان منزجرا عما يعتقد الحرمة فيه، إلا أنه غير مقبول الشهادة على المسلمين
لاجل عداوة ظاهرة تحمله على التقول عليه، وهي عداوة بسبب باطل فتكون مبطلة
للشهادة، ولهذا قلنا: الرق والانوثة والعمى لا تقدح في العدالة أصلا وإن كانت تمنع من قبول الشهادة أو تمكن نقصانا فيها، لانه لا تأثير لهذه المعاني في الحمل على ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه والعدالة تبتنى على ذلك، ولهذا لم يجعل الفاسق والمستور عدلا مطلقا في حكم الشهادة حتى لا يجوز القضاء بشهادة الفاسق وإن كان لو قضى به القاضي نفذ، ولا يجب القضاء بشهادة المستور قبل ظهور حاله.
وقال الشافعي رحمه الله: ولما لم يكن خبر الفاسق والمستور حجة فخبر المجهول أحرى أن لا يكون حجة.
وقلنا نحن: المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته، فيكون خبره حجة على الوجه الذي قررنا.
وأما الاسلام: فهو عبارة عن شريعتنا، وهو نوعان أيضا: ظاهر، وباطن فالظاهر يكون بالميلاد بين المسلمين والنشوء على طريقتها شهادة وعبادة.
والباطن يكون بالتصديق والاقرار بالله كما هو بصفاته وأسمائه والاقرار بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى وقبول أحكامه وشرائعه.
فمن استوصف فوصف ذلك كله فهو مسلم حقيقة، وكذلك إن كان معتقدا لذلك كله.
فقبل أن يستوصف هو مؤمن فيما بينه وبين ربه حقيقة.
وقال في الجامع الكبير: إذا بلغت المرأة فاستوصفت الاسلام فلم تصف فإنها تبين من زوجها.
وقد كنا حكمنا بصحة النكاح بظاهر إسلامها ثم يحكم بفساد النكاح حين لم تحسن أن تصف وجعل ذلك ردة منها.
وقد استقصى بعض مشايخنا في هذا فقالوا: ذكر الوصف على سبيل الاجمال لا يكفي ما لم يكن عالما بحقيقة ما يذكر، لان حفظ الفقه غير حفظ المعنى، ألا ترى أن من يذكر أن محمدا رسول الله ولا يعرف من هو لا يكون مؤمنا به، فإن النصارى يزعمون أنهم يؤمنون بعيسى وعندهم أنه ولد الله فلا يكون ذلك منهم معرفة لعيسى الذي هو عبد الله ورسوله.
ولكنا نقول: في المصير إلى هذا الاستقصاء حرج بين، فالناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا ظاهرا، وأكثرهم لا يقدرون على بيان تفسير
صفات الله تعالى وأسمائه على الحقيقة، ولكن ذكر الاوصاف على الاجمال يكفي
لثبوت الايمان حقيقة، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن الناس بذلك حتى قال للاعرابي الذي شهد برؤية الهلال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ فقال: نعم.
فقال: الله أكبر يكفي المسلمين أحدهم ولما سأله جبريل عن الايمان والاسلام لاجل تعليم الناس معالم الدين بين ذلك على سبيل الاجمال.
وكتاب الله يشهد بذلك، قال تعالى: (فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن) وقد كان هذا الامتحان من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالاستيصاف على الاجمال، وهذا لان المطلق عند الاستيصاف يكون محمولا على الكامل كما هو الاصل، وقد يعجز المرء عن إظهار ما يعتقده بعبارته فينبغي أن يكون الاستيصاف بذكر ذلك على وجه استفهام المخاطب أنه هل يعتقد كذا وكذا، فإذا قال نعم كان مؤمنا حقيقة، وإن كان قال لا أعرف ما تقول أو لا أعتقد ذلك فحينئذ يحكم بكفره، وكذلك من ظهر منه أمارات المعرفة نحو أداء الصلاة بالجماعة مع المسلمين، فإن ذلك يقوم مقام الوصف في الحكم بإيمانه مطلقا، قال عليه السلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد الجماعات فاشهدوا له بالايمان ولا يختلف ما ذكرنا بالرق والحرية والذكورة والانوثة والعمى والبصر، فلهذا جعلنا خبر هؤلاء في كونه حجة في الاحكام الشرعية بصفة واحدة، لان الشرائط التي يبتنى عليها وجوب قبول الخبر يتحقق في الكل.
أما العبد فلا شك في استجماع هذه الشرائط فيه وإن لم يكن من أهل الشهادة لان الاهلية للشهادة تبتنى على الاهلية للولاية على الغير والرق ينفي هذه الولاية، وهذا لان الشهادة تنفيذ القول على الغير وذلك ينعدم في الخبر من وجهين: أحدهما أن المخبر لا يلزم أحدا شيئا ولكن السامع إنما يلتزم باعتقاده أن المخبر عنه مفترض الطاعة (فإذا ترجح جانب الصدق في خبر المخبر ضاهى ذلك المسموع
ممن هو مفترض الطاعة) في اعتقاده فيلزمه العمل باعتبار اعتقاده، كالقاضي يلزمه القضاء بالشهادة بتقلده هذه الامانة لا بإلزام الشاهد إياه، فإن كلام الشاهد يلزم المشهود عليه دون القاضي.
وبيان هذا أن قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بقراءة ليس في ظاهره إلزام أحد شيئا بل بيان صفة تتأدى به الصلاة إذا أرادها، بمنزلة قول
القائل لا خياطة إلا بالابرة.
والثاني أن المخبر يلتزم أولا ثم يتعدى حكم اللزوم إلى غيره من السامعين، فأما الشاهد فإنه يلزم غيره ابتداء، ولهذا جعلنا العبد بمنزلة الحر في الشهادة التي يكون فيها التزام على الوجه الذي يكون في الخبر وهو الشهادة على رؤية هلال رمضان.
ثم قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك فدل أنه كان يعتمد خبره بأن مولاه أذن له.
وسلمان رضي الله عنه حين كان عبدا أتاه بصدقة فاعتمد خبره وأمر أصحابه بالاكل، ثم أتاه بهدية فاعتمد خبره وأكل منه.
وكان يعتمد خبر بريرة رضي الله عنها قبل أن تعتق وبعد عتقها، فدل أن المملوك في حكم قبول الخبر كالحر وأن الانثى في ذلك كالذكر وإن تفاوتا في حكم الشهادة، لانه يشترط العدد في النساء لثبوت معنى الشهادة، وفي باب الخبر العدد ليس بشرط فكما فارق الشهادة الخبر في اشتراط أصل العدد فكذلك في اشتراط العدد في النساء، ألا ترى أن الصحابة كانوا يرجعون إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم من أمر الدين فيعتمدون خبرهن.
وقال رسول الله عليه السلام تأخذون ثلثي دينكم من عائشة وأما العمى فإنه لا يؤثر في الخبر لانه لا يقدح في العدالة، ألا ترى أنه قد كان في الرسل من ابتلي بذلك كشعيب ويعقوب، وكان في الصحابة من ابتلي به كابن أم مكتوم وعتبان بن مالك رضي الله عنهما، وفيهم من كف بصره كابن عباس وابن عمر وجابر وواثلة بن الاسقع رضي الله عنهم، والاخبار المروية عنهم مقبولة، ولم
يشتغل أحد بطلب التاريخ في ذلك أنهم رووا في حالة البصر أم بعد العمى، وهذا بخلاف الشهادة فإن شهادتهم إنما لا تقبل لحاجة الشاهد إلى تمييز بين المشهود له والمشهود عليه عند الاداء وهذا التمييز من البصير يكون بالمعاينة، ومن الاعمى بالاستدلال وبينهما تفاوت يمكن التحرز عنه في جنس الشهود، وفي رواية الخبر لا حاجة إلى هذا التمييز فكان الاعمى والبصير فيه سواء والمحدود في القذف بعد التوبة في رواية الخبر كغيره في ظاهر المذهب، فإن أبا بكرة رضي الله عنه مقبول الخبر ولم يشتغل أحد بطلب التاريخ في خبره أنه روى بعدما أقيم عليه الحد أم قبله، بخلاف
الشهادة فإن رد شهادته من تمام حده ثبت ذلك بالنص، ورواية الخبر ليست في معنى الشهادة، ألا ترى أنه لا شهادة للنساء في الحدود أصلا، وروايتهن في باب الحدود كرواية الرجال، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه لا يكون المحدود في القذف مقبول الرواية لانه محكوم بكذبه بالنص، قال تعالى: (فأولئك عند الله هم الكاذبون) والمحكوم بالكذب فيما يرجع إلى التعاطي لا يكون عدلا، ومن شرط كون الخبر حجة العدالة مطلقا كما بينا.
فصل: في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنى قال بعض أهل الحديث: مراعاة اللفظ في الرواية واجب على وجه لا يجوز النقل بالمعنى من غير مراعاة اللفظ بحال، وذلك منقول عن ابن سيرين.
قال بعض أهل النظر: قول الصحابي على سبيل الحكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله لا يكون حجة بل يجب طلب لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الباب حتى يصح الاحتجاج به، وهذا قول مهجور.
وقال جمهور العلماء مراعاة اللفظ في النقل أولى، ويجوز النقل بالمعنى بعد حسن الضبط على تفصيل نذكره في آخر الفصل.
وقد نقل ذلك عن الحسن والشعبي والنخعي.
فأما من لم يجوز ذلك استدل
بقوله عليه السلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فقد أمر بمراعاة اللفظ في النقل، وبين المعنى فيه وهو تفاوت الناس في الفقه والفهم، واعتبار هذا المعنى يوجب الحجر عاما عن تبديل اللفظ بلفظ آخر، وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من جوامع الكلم والفصاحة في البيان ما هو نهاية لا يدركه فيه غيره، ففي التبديل بعبارة أخرى لا يؤمن التحريف أو الزيادة والنقصان فيما كان مرادا له.
وحجتنا في ذلك ما اشتهر من قول الصحابة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا عن كذا، ولا يمتنع أحد من قبول ذلك إلا من هو متعنت.
وروينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا روى حديثا قال: نحو هذا أو قريبا منه
أو كلاما هذا معناه، وكان أنس رضي الله عنه إذا روى حديثا قال في آخره أو كما قال رسول الله عليه السلام، فدل أن النقل بالمعنى كان مشهورا فيهم، وكذلك العلماء بعدهم يذكرون في تصانيفهم: بلغنا نحوا من ذلك.
وهذا لان نظم الحديث ليس بمعجز والمطلوب منه ما يتعلق بمعناه وهو الحكم من غير أن يكون له تعلق بصورة النظم، وقد علمنا أن الامر بالتبليغ لما هو المقصود به فإذا كمل ذلك بالنقل بالمعنى كان ممتثلا لما أمر به من النقل لا مرتكبا للحرام، وإنما يعتبر النظم في نقل القرآن لانه معجز مع أنه قد ثبت أيضا فيه نوع رخصة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أشار إليه في قوله: أنزل القرآن على سبعة أحرف إلا أن في ذلك رخصة من حيث الاسقاط، وهذا من حيث التخفيف والتيسير، ومعنى الرخصة يتحقق بالطريقين كما تقدم بيانه.
إذا عرفنا هذا فنقول: الخبر إما أن يكون محكما له معنى واحد معلوم بظاهر المتن، أو يكون ظاهرا معلوم المعنى بظاهره على احتمال شئ آخر كالعام الذي يحتمل
الخصوص والحقيقة التي تحتمل المجاز، أو يكون مشكلا، أو يكون مشتركا يعرف المراد بالتأويل، أو يكون مجملا لا يعرف المراد به إلا ببيان، أو يكون متشابها، أو يكون من جوامع الكلم.
فأما المحكم يجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالما بوجوه اللغة، لان المراد به معلوم حقيقة، وإذا كساه العالم باللغة عبارة أخرى لا يتمكن فيه تهمة الزيادة والنقصان.
فأما الظاهر فلا يجوز نقله بالمعنى إلا لمن جمع إلى العلم باللغة العلم بفقه الشريعة، لانه إذا لم يكن عالما بذلك لم يؤمن إذا كساه عبارة أخرى أن لا تكون تلك العبارة في احتمال الخصوص والمجاز مثل العبارة الاولى، وإن كان ذلك هو المراد به، ولعل العبارة التي يروي بها تكون أعم من تلك العبارة لجهله بالفرق بين الخاص والعام، فإذا كان عالما بفقه الشريعة يقع الامن عن هذا التقصير منه عند تغيير العبارة فيجوز له النقل بالمعنى كما كان يفعله الحسن والنخعي والشعبي رحمهم الله.
فأما المشكل والمشترك لا يجوز فيهما النقل بالمعنى أصلا، لان المراد بهما لا يعرف إلا بالتأويل، والتأويل يكون بنوع من الرأي كالقياس فلا يكون حجة على غيره.
وأما المجمل فلا يتصور فيه النقل بالمعنى لانه لا يوقف على المعنى فيه إلا بدليل آخر، والمتشابه كذلك لانا ابتلينا بالكف عن طلب المعنى فيه فكيف يتصور نقله بالمعنى.
وأما ما يكون من جوامع الكلم كقوله عليه السلام: الخراج بالضمان وقوله عليه السلام: العجماء جبار وما أشبه ذلك فقد جوز بعض مشايخنا نقله بالمعنى على الشرط الذي ذكرنا في الظاهر.
قال رضي الله عنه: والاصح عندي أنه لا يجوز ذلك لان النبي عليه السلام كان مخصوصا بهذا النظم على ما روي أنه قال: أوتيت جوامع الكلم أي خصصت بذلك فلا يقدر أحد بعده على ما كان هو مخصوصا به،
ولكن كل مكلف بما في وسعه، وفي وسعه نقل ذلك اللفظ ليكون مؤديا إلى غيره ما سمعه منه بيقين، وإذا نقله إلى عبارته لم يؤمن القصور في المعنى المطلوب به ويتيقن بالقصور في النظم الذي هو من جوامع الكلم، وكان هذا النوع هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم أداها كما سمعها.
فصل: في بيان الضبط بالكتابة والخط قال رضي الله عنه: اعلم بأن الكتابة نوعان: تذكرة، وإمام.
فالتذكرة هو أن ينظر في المكتوب فيتذكر به ما كان مسموعا له، والنقل بهذا الطريق جائز سواء كان مكتوبا بخطه أو بخط غيره، وذلك الخط معروف أو مجهول، لانه إنما ينقل ما يحفظ غير أن النظر في الكتاب كان مذكرا له فلا يكون دون التفكر، ولو تفكر فتذكر جاز له أن يروي ويكون خبره حجة فكذلك إذا نظر في الكتاب فتذكر، ولهذا المقصود ندب إلى الكتاب على ما جاء في الحديث: قيدوا العلم بالكتاب وقال إبراهيم: كانوا يأخذون العلم حفظا ثم أبيح لهم الكتابة لما حدث بهم من الكسل، ولان النسيان مركب في الانسان لا يمكنه أن يحفظ نفسه منه إلا ما كان خاصا لرسول الله عليه السلام بقوله: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
الله ولهذا الاستثناء وقع لرسول الله عليه السلام تردد في قراءته سورة المؤمنين في صلاة الفجر حتى قال لابي رضي الله عنه: (هلا ذكرتني) فثبت أن النسيان مما لا يستطاع الامتناع منه إلا بحرج بين والحرج مدفوع، وبعد النسيان النظر في الكتاب طريق للتذكر والعود إلى ما كان عليه من الحفظ، وإذا عاد كما كان فالرواية تكون عن ضبط تام.
وأما النوع الثاني فهو أن لا يتذكر عند النظر ولكنه يعتمد الخط، وذلك يكون في فصول ثلاثة: رواية الحديث، والقاضي يجد في خريطته سجلا مخطوطا
بخطه من غير أن يتذكر الحادثة، والشاهد يرى خطه في الصك ولا يتذكر الحادثة.
فأبو حنيفة رحمه الله أخذ في الفصول الثلاثة بما هو العزيمة وقال لا يجوز له أن يعتمد الكتاب ما لم يتذكر، لان النظر في الكتاب لمعرفة القلب كالنظر في المرآة للرؤية بالعين، ثم النظر في المرآة إذا لم تفده إدراكا لا يكون معتبرا، فالنظر في الكتاب إذا لم يفده تذكرا يكون هدرا، وهذا لان الرواية والشهادة وتنفيذ القضاء لا يكون إلا بعلم والخط يشبه الخط فبصورة الخط لا يستفيد علما من غير التذكر، وما كان الفساد في سائر الاديان إلا بالاعتماد على الصور بدون المعنى.
وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمهما الله أن في السجل ورواية الاثر يجوز له أن يعتمد الخط وإن لم يتذكر به وفي الصك لا يجوز له ذلك.
وروى ابن رستم عن محمد رحمهما الله أن ذلك جائز في الفصول كلها، وما ذهبنا إليه رخصة للتيسير على الناس.
ثم هذه الرخصة تتنوع أنواعا: إما أن يكون الكتاب بخطه، أو بخط رجل معروف ثقة موقع بتوقيعه، أو بخط رجل معروف غير ثقة أو غير موقع، أو بخط مجهول أما أبو يوسف رحمه الله فقال: السجل يكون في خريطة القاضي مختوما بختمه وكان في يده أيضا فباعتبار الظاهر يؤمن فيه التزوير والتبديل بالزيادة والنقصان، والقاضي مأمور باتباع الظاهر في القضاء فله أن يعتمد السجل في ذلك، وكذلك كتاب المحدث إذا كان في يده، وإن لم يكن السجل في يد القاضي فليس له أن يعتمده لان التزوير والتغيير فيه عادة لما يبتنى عليه من المظالم والخصومات، ومثله في كتاب
الحديث ليس بعادة فلا فرق فيه بين أن يكون في يده أو في يد أمين آخر لم يظهر منه خيانة في مثله، وأما الصك فيكون بيد الخصم فلا يقع الامن فيه عن التغيير والتزوير، حتى إذا كان في يد الشاهد كان الجواب فيه مثل الجواب في السجل.
والحاصل أنه بنى هذه الرخصة على ما يوقع الامن عن التغيير والتعديل عادة، ومحمد رحمه الله أثبت
الرخصة في الصك أيضا وإن لم يكن في يده إذا علم أن المكتوب خطه على وجه لا يبقى فيه شبهة له، لان الباقي بعد ذلك توهم التغيير وله أثر بين يوقف عليه، فإذا لم يظهر ذلك فيه جاز اعتماده، فأما إذا وجد الكتاب بخط بين وهو معلوم عنده أو بخط رجل معروف موثق به فإنه يجوز له أن يقول وجدت بخط فلان كذا لا يزيد على ذلك، ثم إن كان ذلك الخط منفردا ليس معه شئ آخر فإنه لا يكون حجة، وإن كان معه غيره فذلك يوقع الامن عن التزوير بطريق العادة فيجوز اعتماده على وجه الرخصة (وهذا في الاخبار خاصة) فأما في الشهادة والقضاء فلا، لان ذلك من مظالم العباد يعتبر فيه من الاستقصاء ما لا يعتبر في رواية الاخبار واشتراط العلم فيه منصوص عليه، قال تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) وقال عليه السلام للشاهد: إذا رأيت مثل هذا الشمس فاشهد وإلا فدع.
فصل: في بيان وجوه الانقطاع قال رضي الله عنه: اعلم بأن الانقطاع نوعان: انقطاع صورة، وانقطاع معنى.
أما صورة الانقطاع صورة ففي المراسيل من الاخبار، ولا خلاف بين العلماء في مراسيل الصحابة رضي الله عنهم أنها حجة، لانهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما يروونه عن رسول الله عليه السلام مطلقا يحمل على أنهم سمعوه منه أو من أمثالهم، وهم كانوا أهل الصدق والعدالة، وإلى هذا أشار البراء بن عازب رضي الله عنهما بقوله: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما كان يحدث بعضنا بعضا، ولكنا لا نكذب.
فأما مراسيل القرن الثاني والثالث حجة في قول علمائنا رحمهم الله.
وقال الشافعي لا يكون حجة إلا إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة، أو اشتهر العمل به من السلف، أو اتصل من وجه آخر.
قال: ولهذا جعلت مراسيل سعيد بن المسيب حجة لاني اتبعتها
فوجدتها مسانيد.
احتج في ذلك فقال: الخبر إنما يكون حجة باعتبار أوصاف في الراوي ولا طريق لمعرفة تلك الاوصاف في الراوي إذا كان غير معلوم الاصل، فلا تقوم الحجة بمثل هذه الرواية، وإعلامه بالاشارة إليه في حياته وبذكر اسمه ونسبه بعد وفاته، فإذا لم يذكره أصلا فقد تحقق انقطاع هذا الخبر عن رسول الله، والحجة في الخبر باتصاله برسول الله عليه السلام فبعد الانقطاع لا يكون حجة.
ولا يقال إن رواية العدل عنه تكون تعديلا له وإن لم يذكر اسمه، لان طريق معرفة الجرح والعدالة الاجتهاد، وقد يكون الواحد عدلا عند إنسان، مجروحا عند غيره بأن يقف منه على ما كان الآخر لا يقف عليه، ألا ترى أن شهود الفرع إذا شهدوا على شهادة الاصول من غير ذكرهم في شهادتهم لا تكون شهادتهم حجة لهذا المعنى، يوضحه أنه قد كان فيهم من يروي عمن هو مجروح عنده على ما قال الشعبي رحمه الله: حدثني الحارث وكان والله كذابا.
فعرفنا أن بروايته عنه لا يثبت فيه ما يشترط في الراوي فيكون خبره حجة، ولان الناس تكلفوا بحفظ الاسانيد في باب الاخبار، فلو كانت الحجة تقوم بالمراسيل لكان تكلفهم اشتغالا بما لا يفيد فيبعد أن يقال اجتمع الناس على ما ليس بمفيد.
ولكنا نقول: الدلائل التي دلت على كون خبر الواحد حجة من الكتاب والسنة كلها تدل على كون المرسل من الاخبار حجة.
ثم قد ظهر الارسال من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ظهورا لا ينكره إلا متعنت.
أما من الصحابة فبيانه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح جنبا فلا صوم له ولما أنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها قال هي أعلم حدثني به الفضل بن عباس رضي الله عنهما، فقد أرسل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير سماع منه، وقيل إن ابن عباس ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بضعة عشر حديثا وقد كثرت روايته مرسلا، وإنما كان ذلك سماعا من غير
رسول الله عليه السلام، حتى روي أن النبي عليه السلام كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر، وإنما سمع ذلك من أخيه الفضل ونعمان بن بشير رضي الله عنهم، ما سمع من رسول الله عليه السلام إلا حديثا واحدا وهو قوله عليه السلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر جسده، وإذا فسدت فسد سائر جسده ألا وهي القلب ثم كثرت روايته عن رسول الله عليه السلام مرسلا، والحسن وسعيد بن المسيب رضي الله عنهما وغيرهما من أئمة التابعين كان كثيرا ما يروون مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيل أكثر ما رواه سعيد بن المسيب مرسلا إنما سمعه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وقال الحسن: كنت إذا اجتمع لي أربعة من الصحابة على حديث أرسلته إرسالا.
وقال ابن سيرين رضي الله عنه: ما كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة فقال الاعمش: قلت لابراهيم إذا رويت لي حديثا عن عبد الله فأسنده لي، فقال: إذا قلت لك حدثني فلان عن عبد الله فهو ذاك، وإذا قلت لك قال عبد الله فهو غير واحد، ولهذا قال عيسى بن أبان: المرسل أقوى من المسند فإن من اشتهر عنده حديث (بأن سمعه) بطرق طوى الاسناد لوضوح الطريق عنده وقطع الشهادة بقوله قال رسول الله عليه السلام، وإذا سمعه بطريق واحد لا يتضح الامر عنده على وجه لا يبقى له فيه شبهة فيذكره مسندا على قصد أن يحمله من يحمل عنه.
فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يجوز النسخ بالمرسل كما يجوز بين الاخبار بالمشهور عندكم.
قلنا: إنما لم يجز ذلك لان قوة المرسل من هذا الوجه بنوع من الاجتهاد فيكون نظير قوة تثبت بطريق القياس والنسخ بمثله لا يجوز.
ثم رواية هؤلاء الكبار مرسلا، أما إن كان باعتبار سماعهم ممن ليس بعدل عندهم أو باعتبار سماعهم من عدل مع اعتقادهم أن ذلك ليس بحجة أو على اعتقادهم أن المرسل حجة كالمسند، والاول باطل فإن من يستجيز الرواية عمن يعرفه غير عدل بهذه الصفة لا يعتمد روايته مرسلا
ولا مسندا، ولا يجوز أن يظن بهم هذا، والثاني باطل لانه قول بأنهم كتموا موضع
الحجة بترك الاسناد مع علمهم أن الحجة لا تقوم بدونه، فتعين الثالث وهو أنهم اعتقدوا أن المرسل حجة كالمسند وكفى باتفاقهم حجة.
وقال الشافعي في بعض كتبه إنما أرسلوا ليطلب ذلك في المسند: وهذا كلام فاسد، لانه إما أن يقال لم يكن عندهم إسناد ذلك أو كان ولم يذكروا، والاول باطل لان فيه قولا بأنهم تخرصوا ما لم يسمعوا ليطلب ذلك في المسموعات ولا يجوز ذلك لمن هو دونهم فكيف بهم ؟ والثاني باطل لانه إذا كان عندهم الاسناد وقد علموا أن الحجة لا تقوم بدونه فليس في تركه إلا القصد إلى إتعاب النفس بالطلب.
ولو قال من أنكر الاحتجاج بخبر الواحد إنهم إنما رووا ذلك ليطلب ذلك في المتواتر لا يكون هذا الكلام مقبولا منه بالاتفاق فكذلك هذا، يقرره أن المفتي إذا قال للمستفتي قضى رسول الله في هذه الحادثة بكذا كان عليه أن يعمل به، وإن لم يذكر له إسنادا فكذلك إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
ولو قال روى فلان عن فلان قبل ذلك منه وإن لم يقل حدثني ولا سمعته منه، وهذا في معنى الارسال.
فإن قال: إنما نجيزه على هذا الوجه عمن لقي فيحمل مطلق كلامه على المسموع منه.
قلنا: لما جاز حمل كلامه على هذا وإن لم ينص عليه لتحسين الظن به فكذلك يجوز حمل كلامه عند الارسال على السماع ممن هو عدل باعتبار الظاهر لتحسين الظن به، وهذا لانه لا طريق لنا إلى معرفة الشرائط للرواية فيمن لم يدركه إلا بالسماع ممن أدركه، وإذا كان من أدركه عدلا ثقة فإنه لا يروي عنه مطلقا ما لم يعرف استجماع الشرائط فيه، فبروايته عنه يثبت لنا استجماع الشرائط، ألا ترى أنه لو أسند الرواية إليه يثبت استجماع الشرائط فيه بروايته عنه فكذلك إذا أرسله بل أولى، لانه إذا أسند إليه فإنما شهد عليه بأنه روى ذلك، فإذا أرسل فإنما يشهد على رسول الله أنه
قال ذلك، ومن علم أنه لا يستجيز الشهادة على غير رسول الله بالباطل فكيف يظن أن يستجيز الشهادة على رسول الله بالباطل مع قوله عليه السلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يوضحه أن القاضي إذا كتب سجلا فيه قضاؤه في حادثة وأشهد على ذلك كان ذلك حجة وإن لم يبين اسم الشهود في المسجل وما كان ذلك إلا بهذا الطريق، وهذا بخلاف الشهود على شهادة الغير، لان العلماء
مختلفون في أن عند الرجوع هل يجب الضمان على شهود الاصل أم لا فلعل القاضي ممن يرى تضمينهم فلا يتمكن من القضاء به إذا لم يكونوا معلومين عنده ومثل هذا لا يتحقق في باب الاخبار مع أن شاهد الفرع ينوب عن شاهد الاصل في نقل شهادته، ألا ترى أنه لو أشهد قوما على شهادته فسمعه آخرون لم يكن لهم أن يشهدوا على شهادته بخلاف رواية الاخبار، وإذا كان الفرعي يعبر عن الاصل بشهادته لم يجد بدا من ذكره ليكون معبرا، ألا ترى أنه لو قال: أشهد عن فلان لم يكن ذلك مقبولا.
وهنا لو قال أروي عن فلان كان مقبولا منه.
ثم اشتغال الناس بالاسناد كاشتغالهم بالتكلف لسماع الحديث من وجوه، وذلك لا يدل على أن خبر الواحد لا يكون حجة، فكذلك اشتغالهم بالاسناد لا يكون دليلا على أن المرسل لا يكون حجة.
فأما مراسيل من بعد القرون الثلاثة فقد كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله لا يفرق بين مراسيل أهل الاعصار، وكان يقول: من تقبل روايته مسندا تقبل روايته مرسلا.
للمعنى الذي ذكرنا.
وكان عيسى بن أبان رحمه الله يقول: من اشتهر في الناس بحمل العلم منه تقبل روايته مرسلا ومسندا.
وإنما يعني به محمد بن الحسن رحمه الله وأمثاله من المشهورين بالعلم، ومن لم يشتهر بحمل الناس العلم منه مطلقا وإنما اشتهر بالرواية عنه فإن مسنده يكون حجة ومرسله يكون موقوفا إلى أن يعرض على من اشتهر بحمل العلم عنه.
وأصح الاقاويل في هذا ما قاله أبو بكر
الرازي رضي الله عنه أن مرسل من كان من القرون الثلاثة حجة ما لم يعرف منه الرواية مطلقا عمن ليس بعدل ثقة، ومرسل من كان بعدهم لا يكون حجة إلا من اشتهر بأنه لا يروي إلا عمن هو عدل ثقة لان النبي عليه السلام شهد للقرون الثلاثة بالصدق والخيرية فكانت عدالتهم ثابتة بتلك الشهادة ما لم يتبين خلافهم، وشهد على من بعدهم بالكذب بقوله ثم يفشو الكذب، فلا تثبت عدالة من كان في زمن شهد على أهله بالكذب إلا برواية من كان معلوم العدالة يعلم أنه لا يروي إلا عن عدل.
وإلى نحو هذا أشار عروة بن الزبير رضي الله عنهما حين روى لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحيا أرضا ميتة فهي له فقال: أتشهد به على رسول الله عليه السلام ؟ قال: نعم فما يمنعني من ذلك وقد أخبرني به العدل الرضا.
فقبل عمر بن عبد العزيز روايته.
واختلف أصحاب الحديث في منقطع من وجه متصل من وجه آخر.
فمنهم من قال سقط اعتبار الاتصال فيه بالانقطاع من وجه، وكأن هذا القائل جعل الانقطاع بسكوت راوي الفرع عن تسمية راوي الاصل دليل الجرح فيه، وإذا استوى الموجب للعدالة والموجب للجرح يغلب الجرح، وأكثرهم على أن هذا يكون حجة لوجود الاتصال فيه بطريق واحد والطريق الآخر الذي هو منقطع يجعل كأن لبس، لان ذلك الطريق ساكت عن الراوي وحاله أصلا، وفي الطريق المتصل بيان له ولا معارضة بين الساكت والناطق.
فأما النوع الثاني وهو الانقطاع معنى ينقسم قسمين: إما أن يكون ذلك المعنى بدليل معارض، أو نقصان في حال الراوي يثبت به الانقطاع.
فأما القسم الاول وهو ثبوت الانقطاع بدليل معارض فعلى أربعة أوجه: إما أن يكون مخالفا لكتاب الله تعالى، أو لسنة مشهورة عن رسول الله، أو يكون حديثا شاذا لم يشتهر فيما
تعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته، أو يكون حديثا قد أعرض عنه الائمة من الصدر الاول بأن ظهر منهم الاختلاف في تلك الحادثة ولم تجر بينهم المحاجة بذلك الحديث.
فأما الوجه الاول وهو ما إذا كان الحديث مخالفا لكتاب الله تعالى فإنه لا يكون مقبولا ولا حجة للعمل به عاما كانت الآية أو خاصا نصا أو ظاهرا عندنا على ما بينا أن تخصيص العام بخبر الواحد لا يجوز ابتداء، وكذلك ترك الظاهر فيه والحمل على نوع من المجاز لا يجوز بخبر الواحد عندنا خلافا للشافعي، وقد بينا هذا، ودليلنا في ذلك قوله عليه السلام: كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وكتاب الله أحق والمراد كل شرط هو مخالف لكتاب الله تعالى لا أن يكون المراد ما لا يوجد عينه في كتاب الله تعالى فإن عين هذا الحديث لا يوجد في كتاب الله تعالى، وبالاجماع من الاحكام ما هو ثابت بخبر الواحد والقياس وإن كان لا يوجد ذلك في كتاب الله تعالى، فعرفنا أن المراد ما يكون مخالفا لكتاب الله تعالى، وذلك
تنصيص على أن كل حديث هو مخالف لكتاب الله تعالى فهو مردود.
وقال عليه السلام: تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني، وما خالفه فردوه واعلموا أني منه برئ ولان الكتاب متيقن به وفي اتصال الخبر الواحد برسول الله صلى الله عليه وسلم شبهة فعند تعذر الاخذ بهما لا بد من أن يؤخذ بالمتيقن ويترك ما فيه شبهة، والعام والخاص في هذا سواء لما بينا أن العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعا كالخاص، وكذلك النص والظاهر سواء، لان المتن من الكتاب متيقن به ومتن الحديث لا ينفك عن شبهة لاحتمال النقل بالمعنى، ثم قوام المعنى بالمتن فإنما يشتغل بالترجيح من حيث المتن أولا إلى أن يجئ إلى المعنى، ولا شك أن
الكتاب يترجح باعتبار النقل المتواتر في المتن على خبر الواحد، فكانت مخالفة الخبر للكتاب دليلا ظاهرا على الزيافة فيه، ولهذا لم يقبل علماؤنا خبر الوضوء من مس الذكر لانه مخالف للكتاب، فإن الله تعالى قال: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) يعني الاستنجاء بالماء فقد مدحهم بذلك وسمى فعلهم تطهرا ومعلوم أن الاستنجاء بالماء لا يكون إلا بمس الذكر فالحديث الذي يجعل مسه حدثا بمنزلة البول يكون مخالفا لما في الكتاب، لان الفعل الذي هو حدث لا يكون تطهرا.
وكذلك لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس في أن لا نفقة للمبتوتة لانه مخالف للكتاب وهو قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) ولا خلاف أن المراد وأنفقوا عليهن من وجدكم، فالمراد الحائل فإنه عطف عليه قوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) وكذلك لم يقبل خبر القضاء بالشاهد واليمين لانه مخالف للكتاب من أوجه، فإن الله تعالى قال: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) الآية، وقوله: واستشهدوا أمر بفعل هو مجمل فيما يرجع إلى عدد الشهود كقول القائل كل يكون مجملا فيما يرجع إلى عدد الشهود كقول القائل كل يكون مجملا فيما يرجع الى بيان المأكول فيكون ما بعده تفسيرا لذلك المجمل وبيانا لجميع ما هو المراد بالامر وهو استشهاد رجلين فإن لم يكونا فرجل وامرأتان، كقول القائل كل طعام كذا
فإن لم يكن فكذا، أو أذنت لك أن تعامل فلانا فإن لم يكن ففلانا، يكون ذلك بيانا لجميع ما هو المراد بالامر والاذن، وإذا ثبت أن جميع ما هو المذكور في الآية كان خبر القضاء بالشاهد واليمين زائدا عليه والزيادة على النص كالنسخ عندنا، يقرره قوله تعالى: (ذلك أدنى ألا ترتابوا) فقد نص على أن أدنى ما تنتفي به الريبة شهادة شاهدين بهذه الصفة، وليس دون الادنى شئ آخر تنتفي به الريبة، ولانه نقل الحكم من استشهاد الرجل الثاني بعد شهادة الشاهد الواحد إلى استشهاد امرأتين، مع أن
حضور النساء مجالس القضاء لاداء الشهادة خلاف العادة وقد أمرن بالقرار في البيوت شرعا، فلو كان يمين المدعي مع الشاهد الواحد حجة لما نقل الحكم إلى استشهاد امرأتين، وهو خلاف المعتاد، مع تمكن المدعي من إتمام حجته بيمينه.
وبمثل هذا الطريق جعلنا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض حجة، لان الله تعالى نقل الحكم عن استشهاد مسلمين على وصية المسلم إلى استشهاد ذميين بقوله تعالى: (أو آخران من غيركم) مع أن حضور أهل الذمة مجالس القضاة لاداء الشهادة خلاف المعتاد، فذلك دليل ظاهر على أن الحجة تقوم بشهادتهم في الجملة.
وهو دليل أيضا على رد خبر القضاء بالشاهد واليمين لانه نقل الحكم إلى استشهاد ذميين عند عدم شاهدين مسلمين، فلو كان الشاهد الواحد مع يمين المدعي حجة لكان الاولى بيان ذلك عند الحاجة، وذكر في الآية يمين الشاهدين ظاهرا عند الريبة مع أن ذلك ليس بحجة اليوم (لاجل النسخ) فلو كان بيمين المدعي تنتفي الريبة أو تتم الحجة لكان الاولى ذكر يمينه عند الحاجة.
فبهذه الوجوه يتبين أن خبر القضاء بالشاهد واليمين مخالف للكتاب فتركنا العمل به لهذا، وكذلك الغريب من أخبار الآحاد إذا خالف السنة المشهورة فهو منقطع في حكم العمل به، لان ما يكون متواترا من السنة أو مستفيضا أو مجمعا عليه فهو بمنزلة الكتاب في ثبوت علم اليقين به، وما فيه شبهة فهو مردود في مقابلة اليقين، وكذلك المشهور من السنة فإنه أقوى من الغريب لكونه أبعد عن موضع الشبهة، ولهذا جاز النسخ بالمشهور دون الغريب، فالضعيف لا يظهر في مقابلة القوي،
ولهذا لم يعمل بخبر القضاء بالشاهد واليمين، لانه مخالف للسنة المشهورة وهو قوله عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر من وجهين: أحدهما أن في هذا الحديث بيان أن اليمين في جانب المنكر دون المدعي، والثاني أن فيه بيان أنه لا يجمع بين اليمين والبينة فلا تصلح اليمين متممة للبينة بحال، ولهذا الاصل لم يعمل
أبو حنيفة بخبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في بيع الرطب بالتمر أن النبي عليه السلام قال: أينتقص إذا جف ؟ قالوا: نعم.
قال: فلا إذا لانه مخالف للسنة المشهورة وهو قوله عليه السلام: التمر بالتمر مثل بمثل من وجهين: أحدهما أن فيها اشتراط المماثلة في الكيل مطلقا لجواز العقد فالتقييد باشتراط المماثلة في أعدل الاحوال وهو بعد الجفوف يكون زيادة، والثاني أنه جعل فضلا يظهر بالكيل هو الحرام في السنة المشهورة فجعل فضل يظهر عند فوات وصف مرغوب فيه ربا حراما يكون مخالفا لذلك الحكم، إلا أن أبا يوسف ومحمدا قالا: السنة المشهورة لا تتناول الرطب لان مطلق اسم التمر لا يتناوله، بدليل أن من حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا لم يحنث، ولو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله بعد ما صار تمرا لم يحنث، فإذا لم تتناوله السنة المشهورة وجب إثبات الحكم فيه بالخبر الآخر.
وأبو حنيفة قال: التمر اسم للثمرة الخارجة من النخل من حين تنعقد صورتها إلى أن تدرك، وما يختلف عليه أحوال وأوصاف حسب ما يكون على الآدمي لا يتبدل به اسم العين، وفي الايمان تترك الحقائق لدلالة العرف، واليمين تتقيد بوصف في العين إذا كان داعيا إلى اليمين.
ففي هذين النوعين من الانتقاد للحديث علم كثير، وصيانة للدين بليغة، فإن أصل البدع والاهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة، فإن قوما جعلوها أصلا مع الشبهة في اتصالها برسول الله عليه السلام ومع أنها لا توجب علم اليقين، ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة فجعلوا التبع متبوعا، وجعلوا الاساس ما هو غير متيقن به فوقعوا في الاهواء والبدع، بمنزلة من أنكر خبر الواحد فإنه لما لم يجوز العمل به احتاج إلى القياس ليعمل به وفيه أنواع من الشبهة، أو إلى استصحاب الحال وهو ليس
بحجة أصلا وترك العمل بالحجة إلى ما ليس بحجة يكون فتحا لباب الآحاد، وجعل
ما هو غير متيقن به أصلا، ثم تخريج ما فيه التيقن عليه يكون فتحا لباب الاهواء والبدع وكل واحد منهما زيف مردود، وإنما سواء السبيل ما ذهب إليه علماؤنا رحمهم الله من إنزال كل حجة منزلتها، فإنهم جعلوا الكتاب والسنة المشهورة أصلا ثم خرجوا عليهما ما فيه بعض الشبهة وهو المروي بطريق الآحاد مما لم يشتهر، فما كان منه موافقا للمشهور قبلوه، وما لم يجدوا في الكتاب ولا في السنة المشهورة له ذكرا قبلوه أيضا وأوجبوا العمل به، وما كان مخالفا لهما ردوه، على أن العمل بالكتاب والسنة أوجب من العمل بالغريب بخلافه، وما لم يجدوه في شئ من الاخبار وصاروا حينئذ إلى القياس في معرفة حكمه لتحقق الحاجة إليه.
وأما القسم الثالث وهو الغريب فيما يعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به فإنه زيف، لان صاحب الشرع كان مأمورا بأن يبين للناس ما يحتاجون إليه، وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بعدهم، فإذا كانت الحادثة مما تعم به البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة وتعليمهم، وأنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة، فحين لم يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ، ألا ترى أن المتأخرين لما نقلوه اشتهر فيهم، فلو كان ثابتا في المتقدمين لاشتهر أيضا وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته، ولهذا لم تقبل شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية هلال رمضان إذا لم يكن بالسماء علة، ولم يقبل قول الوصي فيما يدعي من إنفاق مال عظيم على اليتيم في مدة يسيرة، وإن كان ذلك محتملا لان الظاهر يكذبه في ذلك، وعلى هذا الاصل لم نعمل بحديث الوضوء من مس الذكر، لان بسرة تفردت بروايته مع عموم الحاجة لهم إلى معرفته.
فالقول بأن النبي عليه السلام خصها بتعليم هذا الحكم مع أنها لا تحتاج إليه ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه شبه المحال، وكذلك خبر الوضوء مما مسته النار، وخبر
الوضوء من حمل الجنازة، وعلى هذا لم يعمل علماؤنا رحمهم الله بخبر الجهر بالتسمية، وخبر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، لانه لم يشتهر النقل فيها مع حاجة الخاص والعام إلى معرفته.
فإن قيل فقد قبلتم الخبر الدال على وجوب الوتر، وعلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الجنابة وهو خبر الواحد فيما تعم به البلوى.
قلنا: لانه قد اشتهر أن النبي عليه السلام فعله وأمر بفعله، فأما الوجوب حكم آخر سوى الفعل وذلك مما يجوز أن يوقف عليه بعض الخواص لينقلوه إلى غيرهم، فإنما قبلنا خبر الواحد في هذا الحكم، فأما أصل الفعل فإنما أثبتناه بالنقل المستفيض.
وأما القسم الرابع وهو ما لم تجر المحاجة به بين الصحابة مع ظهور الاختلاف بينهم في الحكم فإنه زيف، لانهم الاصول في نقل الدين لا يتهمون بالكتمان، ولا يترك الاحتجاج بما هو الحجة والاشتغال بما ليس بحجة، فإذا ظهر منهم الاختلاف في الحكم وجرت المحاجة بينهم فيه بالرأي والرأي ليس بحجة مع ثبوت الخبر، فلو كان الخبر صحيحا لاحتج به بعضهم على بعض، حتى يرتفع به الخلاف الثابت بينهم بناء على الرأي، فكان إعراض الكل عن الاحتجاج به دليلا ظاهرا على أنه سهو ممن رواه بعدهم أو هو منسوخ، وذلك نحو ما يروى الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فإن الكبار من الصحابة اختلفوا في هذا وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلا، فعرفنا أنه غير ثابت أو مؤول، والمراد به أن إيقاع الطلاق إلى الرجال.
وكذلك ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابتغوا في أموال اليتامى خيرا كيلا تأكلها الصدقة فإن الصحابة اختلفوا في وجوب الزكاة في مال الصبي وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلا، فعرفنا أنه غير ثابت إذ
لو كان ثابتا لاشتهر فيهم وجرت المحاجة به بعد تحقق الحاجة إليه بظهور الاختلاف، ففي الانتقاد بالوجهين الاولين تظهر الزيافة معنى للمقابلة، بمنزلة نقد البلد إذا قوبل بنقد أجود منه تظهر الزيافة فيه، وفي الانتقاد بالوجهين الآخرين إظهار الزيافة معنى من حيث إنه تقوي فيه شبهة الانقطاع، بمنزلة نقد تبين فيه زيادة غش على ما هو في
النقد المعهود فيصير زيفا مردودا من هذا الوجه.
والشافعي أعرض عن طلب الانقطاع معنى واشتغل ببناء الحكم على ظاهر الانقطاع في المرسل فترك العمل به مع قوة المعنى فيه كما هو دأبه ودأبنا، فإنه يبني على الظاهر أكثر الاحكام، وعلماؤنا يبنون الفقه على المعاني المؤثرة التي يتضح الحكم عند التأمل فيها.
وأما النوع الثاني وهو ما يبتنى على نقصان حال الراوي فبيان ذلك في فصول: منها خبر المستور، والفاسق، والكافر، والصبي، والمعتوه، والمغفل، والمساهل، وصاحب الهوى.
أما المستور فقد نص محمد رحمه الله في كتاب الاستحسان على أن خبره كخبر الفاسق، وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه بمنزلة العدل في رواية الاخبار لثبوت العدالة له ظاهرا بالحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (وعن عمر رضي الله عنه): المسلمون عدول بعضهم على بعض.
ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستورد فيما يثبت مع الشبهات إذا لم يطعن الخصم، ولكن ما ذكره في الاستحسان أصح في زماننا، فإن الفسق غالب في أهل هذا الزمان فلا تعتمد رواية المستورد ما لم تتبين عدالته كما لم تعتمد شهادته في القضاء قبل أن تظهر عدالته، وهذا بحديث عباد بن كثير أن النبي عليه السلام قال: لا تحدثوا عمن لا تعلمون بشهادته ولان في رواية الحديث معنى الالزام فلا بد من أن يعتمد فيه دليل ملزم وهو العدالة التي تظهر بالتفحص عن أحوال الراوي.
وأما الفاسق فقد ذكر في كتاب الاستحسان أنه إذا أخبر بطهارة الماء أو بنجاسته أو بحل الطعام والشراب وحرمته فإن السامع يحكم رأيه في ذلك، فإن وقع عنده أنه صادق فعليه أن يعمل بخبره وإلا لم يعمل به، وعلى هذا قال بعض مشايخنا رحمهم الله: الجواب كذلك فيما يرويه الفاسق.
قال رضي الله عنه: والاصح عندي أن خبره لا يكون حجة لانه غير مقبول الشهادة وفي حل الطعام وحرمته وطهارة الماء ونجاسته إنما اعتبر خبره إذا تأيد
بأكثر الرأي لاجل الضرورة، لان ذلك حكم خاص ربما يتعذر الوقوف عليه من جهة غيره، ومثل هذه الضرورة لا يتحقق في رواية الخبر فإن في العدول كثرة يمكن الوقوف على معرفة الحديث بالسماع منهم، فلا حاجة إلى الاعتماد على رواية الفاسق فيه.
ثم في المعاملات جعل خبر الفاسق مقبولا لاجل الضرورة أيضا فإن المعاملة تكثر بين الناس ولا يوجد عدل يرجع إليه في كل خبر من ذلك النوع إلا أن ذلك ينفك عن معنى الالزام، فجوز الاعتماد فيه على خبر الفاسق مطلقا، والحل والحرمة فيه معنى الالزام من وجه فلهذا لم نجعل خبر الفاسق فيه معتمدا على الاطلاق حتى ينضم إليه غالب الرأي.
ومن الناس من لم يجعل خبر الفاسق مقبولا في المعاملة أيضا لظاهر قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وروي أن الآية نزلت في الوليد بن عقبة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى قوم فرجع إليه وقال إنهم هموا بقتلي فأراد رسول الله أن يعتمد خبره ويبعث إليهم خيلا لانه ما كان ظاهر الفسق عنده فأنزل الله تعالى هذه الآية، وما أخبر به كان من المعاملات خاليا عن الالزام ومع ذلك أمر الله تعالى بالتوقف في هذا النبأ من الفاسق.
ولكنا نقول: كان ذلك خبرا مستنكرا، فإنه أخبر أنهم ارتدوا بمنع الزكاة وجحودها وهموا بقتله وفيه إلزام الجهاد معهم، ونحن نقول: إن من ثبت فسقه لا يعتبر خبره في
مثل هذا، فأما في المعاملات التي تنفك عن معنى الالزام فيجوز اعتماد خبره لاجل الضرورة، إذ الفسق يرجح معنى الكذب في خبره من غير أن يكون موجبا الحكم بأنه كاذب في خبره لا محالة، ولهذا جعلناه مع الفسق من أهل الشهادة.
فأما الكافر فإنه لا تعتمد روايته في باب الاخبار أصلا.
وكذلك في طهارة الماء ونجاسته إلا أنه إذا وقع في قلب السامع أنه صادق فيما يخبر به من نجاسة الماء فالافضل له أن يريق الماء ثم يتيمم، ولا تجوز صلاته بالتيمم قبل إراقة الماء، لانه لا يعتمد خبره في باب الدين أصلا فيبقى مجرد غلبة الظن وذلك لا يجوز له الصلاة بالتيمم مع وجود الماء، بخلاف الفاسق فهناك يلزمه أن يتوضأ بذلك الماء إذا وقع في قلبه أنه صادق في الاخبار بطهارة
الماء، وإن أخبر بنجاسة الماء ووقع في قلبه أنه صادق فالاولى له أن يريق الماء ويتيمم، فإن تيمم ولم يرق الماء جازت صلاته.
وأما خبر الصبي فقد ذكر في الاستحسان بعد ذكر الفاسق والكافر: وكذلك الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان.
فزعم بعض مشايخنا أن المراد العطف على الفاسق وأن خبره بمنزلة خبر الفاسق في طهارة الماء ونجاسته، والاصح أن المراد عطفه على الكافر، فإن الصبي ليس من أهل الشهادة أصلا كما أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلمين، بخلاف الفاسق فهو من أهل الشهادة وإن لم يكن مقبول الشهادة لفسقه (و) لان الصبي بخبره يلزم الغير ابتداء من غير أن يلتزم شيئا لانه غير مخاطب كالكافر يلزم غيره من غير أن يلتزم، لانه غير معتقد للحكم الذي يخبر به، فأما الفاسق فيلتزم أولا ثم يلزم غيره، ولان الولاية المتعدية تبتنى على الولاية القائمة للمرء على نفسه والفاسق من أهل هذه الولاية فيكون أهلا للولاية
المتعدية أيضا، بخلاف الصبي، والمعتوه بمنزلة الصبي، فقد سوى علماؤنا بينهما في الاحكام في الكتب لنقصان عقلهما.
ومن الناس من يقول رواية الصبي في باب الدين مقبولة وإن لم يكن هو مقبول الشهادة لانعدام الاهلية للولاية بمنزلة رواية العبد، واستدل فيه بحديث أهل قباء، فإن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أتاهم وأخبرهم بتحويل القبلة إلى الكعبة وهم كانوا في الصلاة فاستداروا كهيئتهم، وكان ابن عمر يومئذ صغيرا على ما روي أنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أو يوم أحد على حسب ما اختلف الرواة فيه وهو ابن أربع عشرة سنة فرده، وتحويل القبلة كان قبل بدر بشهرين، فقد اعتمدوا خبره فيما لا يجوز العمل به إلا بعلم وهو الصلاة إلى الكعبة ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولكنا نقول: قد روي أن الذي أتاهم أنس بن مالك، وقد روى عبد الله
بن عمر، فإنا نحمل على أنهما جاء أحدهما بعد الآخر وأخبرا بذلك، وإنما تحولوا معتمدين على خبر البالغ وهو أنس بن مالك، أو كان ابن عمر بالغا يومئذ وإنما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال لضعف بنيته يومئذ لا لانه كان صغيرا فإن ابن أربع عشرة سنة يجوز أن يكون بالغا.
فأما المغفل فإن كان أغلب أحواله التيقظ فهو بمنزلة من لا غفلة به في الرواية والشهادة، لان ما به من الغفلة يسير قلما يخلو العدل عن مثله إلا من عصمه الله تعالى، وإن تفاحش ما به من الغفلة حتى ظهر ذلك في أغلب أموره فهو بمنزلة المعتوه، لان ما يلزم من النقصان في المرء بطريق العادة يجعل بمنزلة الثابت بأصل الخلقة، ألا ترى أنه يترجح معنى السهو والغلط في الرواية باعتبارهما جميعا كما يترجح جانب الكذب باعتبار
فسق الراوي.
وأما المساهل فهو كالمغفل فإنه اسم لمن يجازف في الامور ولا يبالي بما يقع له من السهو والغلط، ولا يشتغل فيه بالتدارك بعد أن يعلم به، فيكون بمنزلة المغفل إذا ظهر ذلك في أكثر أموره.
وأما صاحب الهوى فقد بينا أن الصحيح أنه لا تعتمد روايته في أحكام الدين وإن كانت شهادتهم مقبولة إلا الخطابية، فإن الهوى لا يكون مرجحا جانب الكذب في شهادته على ما قررنا، إلا الخطابية وهم ضرب من الروافض يجوزون أداء الشهادة إذا حلف المدعي بين أيديهم أنه محق في دعواه، ويقولون المسلم لا يحلف كاذبا، ففي هذا الاعتقاد ما يرجح جانب الكذب في شهادتهم لتوهم أنهم اعتمدوا ذلك.
وكذلك قالوا فيمن يعتقد أن الالهام حجة موجبة للعلم لا تقبل شهادته لتوهم أن يكون اعتمد ذلك في أداء
الشهادة بناء على اعتقاده.
فأما من سواهم من أهل الاهواء ليس فيما يعتقدون من الهوى ما يمكن تهمة الكذب في شهادتهم، لان الشهادة من باب المظالم والخصومات، ولا يتعصب صاحب الهوى بهذا الطريق مع من هو محق في اعتقاده حتى يشهد عليه كاذبا، فأما في أخبار الدين فيتوهم بهذا التعصب لافساد طريق الحق على من هو محق حتى يجيبه إلى ما يدعو إليه من الباطل، فلهذا لا تعتمد روايته ولا تجعل حجة في باب الدين، والله أعلم.
فصل: في بيان أقسام الاخبار قال رضي الله عنه: هذه الاقسام أربعة: خبر يحيط العلم بصدقه، وخبر يحيط العلم بكذبه، وخبر يحتملهما على السواء، وخبر يترجح فيه
أحد الجانبين.
فالاول: أخبار الرسل المسموعة منهم، فإن جهة الصدق متعين فيها لقيام الدلالة على أنهم معصومون عن الكذب وثبوت رسالتهم بالمعجزات الخارجة عن مقدور البشر عادة، وحكم هذا النوع اعتقاد الحقية فيه والائتمار به بحسب الطاقة، قال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) .
والنوع الثاني: نحو دعوى فرعون الربوبية مع قيام آيات الحدث فيه ظاهرا، ودعوى الكفار أن الاصنام آلهة أو أنها شفعاؤهم عند الله، أو أنها تقربهم إلى الله زلفى مع التيقن بأنها جمادات، ونحو دعوى زرادشت وماني ومسيلمة وغيرهم من المتنبئين النبوة مع ظهور أفعال تدل على السفه منهم، وأنهم لم يبرهنوا على ذلك إلا بما هو مخرفة من جنس أفعال المشعوذين، فالعلم يحيط بكذب هذا النوع، وحكمه اعتقاد البطلان فيه ثم الاشتغال برده باللسان واليد بحسب ما تقع الحاجة إليه في دفع الفتنة.
والنوع الثالث: نحو خبر الفاسق في أمر الدين، ففيه احتمال الصدق باعتبار
دينه وعقله، واحتمال الكذب باعتبار تعاطيه، واستوى الجانبان في الاحتمال فالحكم فيه التوقف إلى أن يظهر ما يترجح به أحد الجانبين عملا بقوله تعالى: (فتبينوا) .
والنوع الرابع: نحو شهادة الفاسق إذا ردها القاضي، فإن بقضائه يترجح جانب الكذب فيه، وخبر المحدود في القذف عند إقامة الحد عليه، وحكمه أنه لا يجوز العمل به بعد ذلك لتعين جانب الكذب فيه فيما يوجب العمل.
ومن هذا النوع خبر العدل المستجمع لشرائط الرواية في باب الدين، فإنه يترجح
جانب الصدق فيه بوجود دليل شرعي موجب للعمل به وهو صالح للترجيح، والمقصود هذا النوع.
ولهذا النوع أطراف ثلاثة: طرف السماع، وطرف الحفظ، وطرف الاداء.
فطرف السماع نوعان: عزيمة، ورخصة.
فالعزيمة ما تكون بحسب الاستماع.
وهو أربعة أوجه: وجهان من ذلك حقيقة وأحدهما أحق من الآخر، ووجهان من ذلك عزيمة فيهما شبهة الرخصة.
فالوجهان الاولان قراءة المحدث عليك وأنت تسمع، وقراءتك على المحدث وهو يسمع، ثم استفهامك إياه بقولك أهو كما قرأت عليك فيقول نعم، وأهل الحديث يقولون الوجه الاول أحق لانه طريق رسول الله عليه السلام، وهو الذي كان يحدث أصحابه ثم نقلوه عنه، وهو أبعد من الخطأ والسهو فيكون أحق فيما هو المقصود وهو تحمل الامانة بصفة تامة.
وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أن قراءتك على المحدث أقوى من قراءة المحدث عليك، وإنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لكونه مأمون السهو والغلط، ولانه كان يذكر ما يذكره حفظا، وكان لا يكتب ولا يقرأ المكتوب أيضا، وإنما كلامنا فيمن يخبر عن كتاب لا عن (حفظه حتى إذا كان يروي عن حفظ لا عن كتاب فقراءته أقوى لانه يتحدث به) حقيقة، فأما إذا كان يروي عن كتاب فالجانبان
سواء في معنى التحدث بما في الكتاب، ألا ترى أن في الشهادات لا فرق بين أن يقرأ من عليه الحق ذكر إقراره عليك وبين أن تقرأه عليه، ثم تستفهمه هل تقر بجميع ما قرأته عليك فيقول نعم، وبكل واحد من الطريقين يجوز أداء الشهادة، وباب الشهادة أضيق من باب رواية الخبر، فكان المعنى فيه أن نعم جواب مختصر ولا فرق في الجواب بين المختصر والمشبع، فيصير
ما تقدم كالمعاد في الجواب كله، ثم للطالب من الرعاية عند القراءة عادة ما ليس للمحدث، فعند قراءة المحدث لا يؤمن من الخطأ في بعض ما يقرأ لقلة رعايته، ويؤمن ذلك إذا قرأ الطالب لشدة رعايته.
فإن قيل عند قراءة الطالب يتوهم أن يسهو المحدث عن بعض ما يسمع وينتفي هذا التوهم إذا قرأه المحدث لشدة رعاية الطالب في ضبط ما يسمع منه.
قلنا: هو كذلك ولكن السهو عن سماع البعض مما لا يمكن التحرز عنه عادة وهو أيسر مما يقع بسبب الخطأ في القراءة، فمراعاة ذلك الجانب أولى.
والوجهان الآخران الكتابة والرسالة، فإن المحدث إذا كتب إلى غيره على رسم الكتب وذكر في كتابه: حدثني فلان عن فلان إلى آخره، ثم قال: وإذا جاءك كتابي هذا وفهمت ما فيه فحدث به عني فهذا صحيح.
وكذلك لو أرسل إليه رسولا فبلغه على هذه الصفة، فإن رسول الله عليه السلام كان مأمورا بتبليغ الرسالة، وبلغ إلى قوم مشافهة وإلى آخرين بالكتاب والرسول وكان ذلك تبليغا تاما.
وكذلك في زماننا يثبت من الخلفاء تقليد السلطنة والقضاء بالكتاب والرسول بهذا الطريق كما يثبت بالمشافهة، إلا أن المختار في الوجهين الاولين للراوي أن يقول حدثني فلان، وفي الوجهين الآخرين أن يقول أخبرني، لان في الوجهين الاولين شافهه المحدث بالاسماع فيكون محدثا له، وفي الوجهين الآخرين لم يشافهه ولكنه مخبر له بكتابه، فإن الكتاب ممن بعد كالخطاب ممن حضر، والرسول كالكتاب أو أقوى لان معنى الضبط يوجد فيهما، ثم الرسول ناطق والكتاب غير ناطق.
وعلى هذا ذكر في الزيادات: إذا حلف أن لا يتحدث بسر فلان أو لا يتكلم
به فكتب به أو أرسل رسولا لم يحنث، ولو تكلم به مشافهة يحنث،
ولو حلف لا يخبر به فكتب أو أرسل يحنث بمنزلة ما لو تكلم به.
والدليل عليه أن الله تعالى أكرمنا بكتابه ورسوله، ثم لا يجوز لاحد أن يقول حدثني الله ولا كلمني الله، إنما ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام خاصة كما قال تعالى: (وكلم الله موسى تكليما) ويجوز أن يقول أخبرنا الله بكذا أو أنبأنا ونبأنا، فلهذا كان المختار في الوجهين الاولين حدثني وفي الوجهين الآخرين أخبرني.
وأما الرخصة فيه فمما لا تكون فيه إسماع، وذلك الاجازة والمناولة، وشرط الصحة في ذلك أن يكون ما في الكتاب معلوما للمجاز له مفهوما له، وأن يكون المجيز من أهل الضبط والاتقان قد علم جميع ما في الكتاب، وإذا قال حينئذ أجزت لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب كان صحيحا، لان الشهادة تصح بهذه الصفة، فإن الشاهد إذا وقف على جميع ما في الصك، وكان ذلك معلوما لمن عليه الحق فقال أجزت لك أن تشهد علي بجميع ما في هذا الكتاب كان صحيحا فكذلك رواية الخبر، والاحوط للمجاز له أن يقول عند الرواية أجاز لي فلان، فإن قال أخبرني فهو جائز أيضا وليس ينبغي له أن يقول حدثني، فإن ذلك مختص بالاسماع ولم يوجد.
والمناولة لتأكيد الاجازة فيستوى الحكم فيما إذا وجدا جميعا أو وجدت الاجازة وحدها.
فأما إذا كان المستجيز غير عالم بما في الكتاب فقد قال بعض مشايخنا إن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تصح هذه الاجازة، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تصح على قياس اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي وكتاب الشهادة، فإن علم الشاهد بما في الكتاب شرط في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، ولا يكون شرطا في قول أبي يوسف رحمه الله لصحة أداء الشهادة.
قال رضي الله عنه: والاصح عندي أن هذه الاجازة لا تصح في
قولهم جميعا إلا أن أبا يوسف استحسن هناك لاجل الضرورة، فالكتب تشتمل على أسرار لا يريد الكاتب والمكتوب إليه أن يقف عليها غيرهما وذلك لا يوجد في كتب الاخبار.
ثم الخبر أصل الدين أمره عظيم، وخطبه جسيم، فلا وجه للحكم بصحة تحمل الامانة فيه قبل أن يصير معلوما مفهوما له، ألا ترى أنه لو قرأ عليه المحدث فلم يسمع ولم يفهم لم يجز له أن يروي، والاجازة إذا لم يكن ما في الكتاب معلوما له دون ذلك كيف تجوز الرواية بهذا القدر، وإسماع الصبيان الذين لا يميزون ولا يفهمون نوع تبرك استحسنه الناس، فأما أن يثبت بمثله نقل الدين فلا.
وكذلك من حضر مجلس السماع واشتغل بقراءة كتاب آخر غير ما يقرؤه القارئ، أو اشتغل بالكتابة لشئ آخر أو اشتغل بتحدث أو لغو أو لهو، أو اشتغل عن السماع لغفلة أو نوم، فإن سماعه لا يكون صحيحا مطلقا له الرواية إلا أن مقدار ما لا يمكن التحرز عنه من السهو والغفلة يجعل عفوا للضرورة، فأما عند القصد فهو غير معذور ولا يأمن أن يحرم بسبب ذلك حظه ونعوذ بالله، فأما إذا قال المحدث: أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي فإن ذلك غير صحيح بالاتفاق، بمنزلة ما لو قال رجل لآخر اشهد علي بكل صك تجد فيه إقراري فقد أجزت لك ذلك فإن ذلك باطل.
وقد نقل عن بعض أئمة التابعين أن سائلا سأله الاجازة بهذه الصفة فتعجب وقال لاصحابه: هذا يطلب مني أن أجيز له أن يكذب علي ! وبعض المتأخرين جوزوا ذلك على وجه الرخصة لضرورة المستعجلين، ولكن في هذه الرخصة سد باب الجهد في الدين، وفتح باب الكسل فلا وجه للمصير إليه.
فأما الكتب المصنفة التي هي مشهورة في أيدي الناس فلا بأس لمن
نظر فيها، وفهم شيئا منها، وكان متقنا في ذلك أن يقول: قال فلان كذا أو مذهب فلان كذا من غير أن يقول حدثني أو أخبرني، لانها مستفيضة بمنزلة الخبر المشهور، وبعض الجهال من المحدثين استبعدوا ذلك حتى طعنوا على محمد رحمه الله في كتبه المصنفة.
وحكي أن بعضهم قال لمحمد بن الحسن رحمه الله: أسمعت هذا كله من أبي حنيفة ؟ فقال: لا.
فقال: أسمعته من
أبي يوسف ؟ فقال: لا وإنما أخذنا ذلك مذاكرة.
فقال: كيف يجوز إطلاق القول بأن مذهب فلان كذا أو قال فلان كذا بهذا الطريق ؟ ! وهذا جهل لان تصنيف كل صاحب مذهب معروف في أيدي الناس مشهور كموطأ مالك رحمه الله وغير ذلك فيكون بمنزلة الخبر المشهور يوقف به على مذهب المصنف، وإن لم نسمع منه فلا بأس بذكره على الوجه الذي ذكرنا بعد أن يكون أصلا معتمدا يؤمن فيه التصحيف والزيادة والنقصان.
فأما بيان طرق الحفظ فهو نوعان: عزيمة ورخصة.
فالعزيمة فيه أن يحفظ المسموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الاداء، وكان هذا مذهب أبي حنيفة في الاخبار والشهادات جميعا، ولهذا قلت روايته، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه للناس.
وأما الرخصة فيه أن يعتمد الكتاب إلا أنه إذا نظر في الكتاب فتذكر فهو عزيمة أيضا ولكنه مشبه بالرخصة، وإذا لم يتذكر فهو محض الرخصة على قول من يجوز ذلك، وقد بينا فيما سبق.
والاداء أيضا نوعان: عزيمة، ورخصة.
فالعزيمة أن يؤدي على الوجه الذي سمعه بلفظه ومعناه، والرخصة فيه أن يؤدي بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه، وقد بينا ذلك.
ومن نوع الرخصة التدليس وهو أن يقول قال فلان كذا
لمن لقيه ولكن لم يسمع منه، فيوهم السامعين أنه قد سمع ذلك منه، وكان الاعمش والثوري يفعلان ذلك، وكان شعبة يأبى ذلك ويستبعده غاية الاستبعاد حتى كان يقول: لان أزني أحب إلي من أن أدلس.
والصحيح القول الاول، وقد بينا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك فيقول الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإذا روجع فيه قال سمعته من فلان يرويه عن رسول الله عليه السلام، وما كان ينكر بعضهم على بعض ذلك، فعرفنا أنه لا بأس به وأن هذا النوع لا يكون تدليسا مطلقا، فإنه لا يجوز لاحد أن يسمي أحدا من الصحابة مدلسا، وإنما التدليس المطلق أن يسقط اسم من
رواه له ويروى عن راوي الاصل على قصد الترويج بعلو الاسناد، فإن هذا القصد غير محمود، فأما إذا لم يكن على هذا القصد وإنما كان على قصد التيسير على السامعين بإسقاط تطويل الاسناد عنهم، أو على قصد التأكيد بالعزم على أنه قول رسول الله عليه السلام قطعا فهذا لا بأس به، وما نقل عن الصحابة والتابعين محمول على هذا النوع.
وتجوز الرواية عمن اشتهر بهذا الفعل إذا علم أنه لا يدلس إلا فيما سمعه عن ثقة، فأما إذا كان يروي عمن ليس بثقة ويدلس بهذه الصفة لا تجوز الرواية عنه بعدما اشتهر بالتدليس.
واختلف العلماء في فصل من هذا الجنس وهو أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو السنة كذا، فالمذهب عندنا أنه لا يفهم من هذا المطلق الاخبار بأمر رسول الله عليه السلام أو أنه سنة رسول الله.
وقال الشافعي في القديم: ينصرف إلى ذلك عند الاطلاق، وفي الجديد قال: لا ينصرف إلى ذلك بدون البيان لاحتمال أن يكون المراد سنة البلدان أو الرؤساء، حتى قال في كل موضع قال مالك رحمه الله السنة ببلدنا كذا: فإنما أراد سنة سليمان بن بلال وهو
كان عريفا بالمدينة، وعلى قوله القديم أخذ بقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه في العاجز عن النفقة إنه يفرق بينه وبين امرأته لانه حمل قول سعيد السنة، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وكذلك أخذ بقوله في أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية بقول سعيد فيه السنة، فحمل ذلك على سنة رسول الله عليه السلام.
ولم نأخذ نحن بذلك لانا علمنا أن مراده سنة زيد، ورجحنا قول علي وعبد الله رضي الله عنهما على قول زيد رضي الله عنه بالقياس الصحيح.
وحجتنا في ذلك أن الامر والنهي يتحقق من غير رسول الله عليه السلام كما يتحقق منه، قال تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) وعند الاطلاق لا يثبت إلا أدنى الكمال، ألا ترى أن مطلق قول العالم أمرنا بكذا لا يحمل على أنه أمر الله أنزله في كتابه نصا، فكذلك لا يحمل على أنه أمر رسول الله عليه السلام نصا لاحتمال أن يكون الآمر غيره ممن يجب متابعته.
وكذلك السنة، فقد قال عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي وقال عليه السلام: من سن سنة حسنة فله
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وقد ظهر من عادة الصحابة التقييد عند إرادة سنة رسول الله عليه السلام بالاضافة إليه على ما قال عمر لصبي بن معبد: هديت لسنة نبيك.
وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه السلام أن نصلي فيهن.
وقال صفوان بن عسال رضي الله عنه: (أمرنا رسول الله عليه السلام إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها) الحديث.
فبهذا يتبين أنهم إذا أطلقوا هذا اللفظ فإنه لا يكون مرادهم الاضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا، ومع الاحتمال لا يثبت التعيين بغير دليل.
تم بتوفيق الله تعالى وعونه الجزء الاول من اصول الامام السرخسى
رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وكذلك أخذ بقوله في أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية بقول سعيد فيه السنة، فحمل ذلك على سنة رسول الله عليه السلام.
ولم نأخذ نحن بذلك لانا علمنا أن مراده سنة زيد، ورجحنا قول علي وعبد الله رضي الله عنهما على قول زيد رضي الله عنه بالقياس الصحيح.
وحجتنا في ذلك أن الامر والنهي يتحقق من غير رسول الله عليه السلام كما يتحقق منه، قال تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) وعند الاطلاق لا يثبت إلا أدنى الكمال، ألا ترى أن مطلق قول العالم أمرنا بكذا لا يحمل على أنه أمر الله أنزله في كتابه نصا، فكذلك لا يحمل على أنه أمر رسول الله عليه السلام نصا لاحتمال أن يكون الآمر غيره ممن يجب متابعته.
وكذلك السنة، فقد قال عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي وقال عليه السلام: من سن سنة حسنة فله
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وقد ظهر من عادة الصحابة التقييد عند إرادة سنة رسول الله عليه السلام بالاضافة إليه على ما قال عمر لصبي بن معبد: هديت لسنة نبيك.
وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه السلام أن نصلي فيهن.
وقال صفوان بن عسال رضي الله عنه: (أمرنا رسول الله عليه السلام إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها) الحديث.
فبهذا يتبين أنهم إذا أطلقوا هذا اللفظ فإنه لا يكون مرادهم الاضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا، ومع الاحتمال لا يثبت التعيين بغير دليل.
تم بتوفيق الله تعالى وعونه الجزء الاول من اصول الامام السرخسى ويليه الجزء الثاني، واوله: (فصل في الخبر بلحقه التكذيب من جهة الراوى أو من جهة غيره).
أصول السرخسي - أبو بكر السرخسي ج 2
أصول السرخسي
أبو بكر السرخسي ج 2
اصول السرخسي للامام الفقيه الاصولي النظار ابى بكر محمد بن احمد بن ابى سهل السرخسى المتوفى سنة 490 من الهجرة النبوية رضى الله عنه الجزء الثاني حقق أصوله أبو الوفاء الافغاني رئيس اللجنة العلمية لاحياء المعارف النعمانية عنيت بنشره لجنة احياء المعارف النعمانية بحيدر اباد الدكن بالهند دار الكتاب العلمية بيروت لبنان
الطبعة الاولى 1414 ه.
- 1993 م.
بسم الله الرحمن الرحيم فصل: في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره أما ما يلحقه من جهة الراوي فأربعة أقسام: أحدها أن ينكر الرواية أصلا، والثاني أن يظهر منه مخالفة للحديث قولا أو عملا قبل الرواية أو بعدها، أو لم يعلم التاريخ، والثالث أن يظهر منه تعيين شئ مما هو من محتملات الخبر تأويلا أو تخصيصا،
والرابع أن يترك العمل بالحديث أصلا.
فأما الوجه الاول فقد اختلف فيه أهل الحديث من السلف فقال بعضهم: بإنكار الراوي يخرج الحديث من أن يكون حجة.
وقال بعضهم: لا يخرج (من أن يكون حجة) وبيان هذا فيما رواه ربيعة عن سهيل بن أبي صالح من حديث القضاء بالشاهد واليمين، ثم قيل لسهيل: إن ربيعة يروي عنك هذا الحديث فلم يذكره وجعل يروي ويقول حدثني ربيعة عني وهو ثقة.
وقد عمل الشافعي بالحديث مع إنكار الراوي ولم يعمل به علماؤنا رحمهم الله.
وذكر سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث، ثم روى أن ابن جريج سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه، ثم عمل به محمد والشافعي مع إنكار الراوي، ولم يعمل به أبو حنيفة وأبو يوسف لانكار الراوي إياه، وقالوا ينبغي أن يكون هذا الفصل على الاختلاف بين علمائنا رحمهم الله بهذه الصفة، واستدلوا عليه بما لو ادعى رجل عند قاض أنه قضى له بحق على هذا الخصم ولم يعرف القاضي قضاءه فأقام المدعي شاهدين على قضائه بهذه الصفة، فإن على قول أبي يوسف لا يقبل القاضي هذه البينة ولا ينفذ قضاءه بها وعلى قول محمد يقبلها وينفذ قضاءه، فإذا ثبت هذا الخلاف بينهما في قضاء ينكره القاضي فكذلك في حديث ينكره الراوي الاصل.
وعلى هذا ما يحكي من المحاورة التي جرت بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في الرواية عن أبي حنيفة في ثلاث مسائل من
الجامع الصغير، وقد بيناها في شرح الجامع الصغير، فإن محمدا ثبت على ما رواه عن أبي يوسف عنه بعد إنكار أبي يوسف، وأبو يوسف لم يعتمد رواية محمد عنه حين لم يتذكر.
وزعم بعض مشايخنا أن على قياس قول علمائنا ينبغي أن لا يبطل الخبر بإنكار راوي الاصل إلا على قول زفر رحمه الله، وردوا هذا إلى قول زوج المعتدة
أخبرتني أن عدتها قد انقضت وهي تنكر فإن على قول زفر لا يبقى الخبر معمولا به بعد إنكارها، وعندنا يبقى معمولا به إلا في حقها، والاول أصح، فإن جواز نكاح الاخت والاربع له هنا عندنا باعتبار ظهور انقضاء العدة في حقه (بقوله) لكونه أمينا في الاخبار عن أمر بينه وبين ربه لا لاتصال الخبر بها، ولهذا لو قال انقضت عدتها ولم يضف الخبر إليها كان الحكم كذلك في الصحيح من الجواب.
فأما الفريق الاول فقد احتجوا بحديث ذي اليدين رضي الله عنه، فإن النبي عليه السلام لما قال لابي بكر وعمر رضي الله عنهما: (أحق ما يقول ذو اليدين ؟) فقالا نعم، فقام فأتم صلاته وقبل خبرهما عنه وإن لم يذكره، وعمر قبل خبر أنس بن مالك عنه في أمان الهرمزان بقوله له أتكلم كلام حي وإن لم يذكر ذلك، ولان النسيان غالب على الانسان فقد يحفظ الانسان شيئا ويرويه لغيره ثم ينسى بعد مدة فلا يتذكره أصلا، والراوي عنه عدل ثقة فبه يترجح جانب الصدق في خبره ثم لا يبطل ذلك بنسيانه.
وهذا بخلاف الشهادة على الشهادة فإن شاهد الاصل إذا أنكره لم يكن للقاضي أن يقضي بشهادته، لان الفرعي هناك ليس بشاهد على الحق ليقضي بشهادته، وإنما هو ثابت في نقل شهادة الاصلي، ولهذا لو قال أشهد على فلان لا يكون صحيحا ما لم يقل أشهدني على شهادته وأمرني بالاداء فأنا أشهد على شهادته، ثم القضاء يكون بشهادة الاصلي ومع إنكار لا تثبت شهادته في مجلس القضاء، فأما هنا الفرعي إنما يروي الحديث باعتبار سماع صحيح له من الاصلي ولا يبطل ذلك بإنكار الاصلي بناء على نسيانه.
وأما الفريق الثاني استدلوا بحديث عمار رضي الله عنه حين قال لعمر: أما تذكر إذ كنا في الابل فأجنبت فتمعكت في التراب ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما كان يكفيك أن تضرب بيديك الارض فتمسح بهما وجهك وذراعيك فلم
يرفع عمر رضي الله عنه رأسه ولم يعتمد روايته مع أنه كان عدلا ثقة، لانه روى عنه
ولم يتذكر هو ما رواه فكان لا يرى التيمم للجنب بعد ذلك، ولان باعتبار تكذيب العادة يخرج الحديث من أن يكون حجة موجبة للعمل كما قررنا فيما سبق، وتكذيب الراوي أدل على الوهن من تكذيب العادة، وهذا لان الخبر إنما يكون معمولا به إذا اتصل برسول الله عليه السلام، وقد انقطع هذا الاتصال بإنكار راوي الاصل، لان إنكاره حجة في حقه فتنتفي به روايته الحديث أو يصير هو مناقضا بإنكاره ومع التناقض لا تثبت روايته وبدون روايته لا يثبت الاتصال فلا يكون حجة كما في الشهادة على الشهادة، وكما يتوهم نسيان راوي الاصل يتوهم غلط راوي الفرع، فقد يسمع الانسان حديثا فيحفظه ولا يحفظ من سمع منه فيظن أنه سمعه من فلان وإنما سمعه من غيره، فأدنى الدرجات فيه أن يقع التعارض فيما هو متوهم فلا يثبت الاتصال من جهته ولا من جهة غيره لانه مجهول وبالمجهول لا يثبت الاتصال.
وأما حديث ذي اليدين فإنما يحمل على أن النبي عليه السلام تذكر ذلك عند خبرهما وهذا هو الظاهر، فإنه كان معصوما عن التقرير على الخطأ، وحديث عمر محتمل لذلك أيضا فربما تذكر حين شهد به غيره فلهذا عمل به، أو تذكر غفلة من نفسه وشغل القلب بشئ في ذلك الوقت، وقد يكون هذا للمرء بحيث يوجد شئ منه ثم لا يذكره، فأخذه بالاحتياط وجعله آمنا من هذا الوجه.
ونحن لا نمنع من مثل هذا الاحتياط، وإنما ندعي أنه لا يبقى موجبا للعمل مع إنكار راوي الاصل، وكما أن راوي الفرع عدل ثقة فراوي الاصل كذلك وذلك يرجح جانب الصدق في إنكاره أيضا فتتحقق المعارضة من هذا الوجه، وأدنى ما فيه أن يتعارض قولاه في الرواية والانكار فيبقى الامر على ما كان قبل روايته.
وأما الوجه الثاني وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قولا أو عملا، فإن كان ذلك بتاريخ قبل الرواية فإنه لا يقدح في الخبر ويحمل على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الحديث فلما سمع الحديث رجع إليه، وكذلك إن لم يعلم التاريخ لان الحمل على أحسن
الوجهين واجب ما لم يتبين خلافه، وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه الحديث
ثم رجع إلى الحديث.
وأما إذا علم ذلك منه بتاريخ بعد الحديث فإن الحديث يخرج به من أن يكون حجة لان فتواه بخلاف الحديث أو عمله من أبين الدلائل على الانقطاع وأنه الاصل للحديث، فإن الحالات لا تخلو إما إن كانت الرواية تقولا منه لا عن سماع فيكون واجب الرد، أو تكون فتواه وعمله بخلاف الحديث على وجه قلة المبالاة والتهاون بالحديث فيصير به فاسقا لا تقبل روايته أصلا، أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيان وشهادة المغفل لا تكون حجة فكذلك خبره، أو يكون ذلك منه على أنه علم انتساخ حكم الحديث، وهذا أحسن الوجوه فيجب الحمل عليه تحسينا للظن بروايته وعمله، فإنه روى على طريق إبقاء الاسناد وعلم أنه منسوخ فأفتى بخلافه، أو عمل بالناسخ دون المنسوخ، وكما يتوهم أن يكون فتواه أو عمله بناء على غفلة أو نسيان يتوهم أن تكون روايته بناء على غلط وقع له وباعتبار التعارض بينهما ينقطع الاتصال.
وبيان هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: يغسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا ثم صح من فتواه أنه يطهر بالغسل ثلاثا فحملنا على أنه كان علم انتساخ هذا الحكم، أو علم بدلالة الحال أن مراد رسول الله عليه السلام الندب فيما وراء الثلاثة.
وقال عمر رضي الله عنه: متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه السلام وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج.
فإنما يحمل هذا على علمه بالانتساخ، ولهذا قال ابن سيرين هم الذين رووا الرخصة في المتعة وهم الذين نهوا عنها، وليس في رأيهم ما يرغب عنه ولا في نصيحتهم ما يوجب التهمة.
وأما في العمل فبيان هذا في حديث عائشة رضي الله عنها: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها) ثم صح أنها زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، فبعملها بخلاف الحديث يتبين النسخ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
عليه السلام كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الرجوع، ثم قد صح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر سنين وكان لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح فيثبت بعمله بخلاف الحديث نسخ الحكم.
وأما الوجه الثالث وهو تعيينه بعض محتملات الحديث فإن ذلك لا يمنع كون الحديث معمولا به على ظاهره من قبل أنه إنما فعل ذلك بتأويل وتأويله لا يكون
حجة على غيره، وإنما الحجة الحديث، وبتأويله لا يتغير ظاهر الحديث فيبقى معمولا به على ظاهره، وهو وغيره في التأويل والتخصيص سواء.
وبيان هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا يحتمل التفرق بالاقوال ويحتمل التفرق بالابدان ثم حمله ابن عمر على التفرق بالابدان حتى روى عنه أنه كان إذا أوجب البيع مشى هنيهة، ولم نأخذ بتأويله لان الحديث في احتمال كل واحد من الامرين كالمشترك فتعيين أحد المحتملين فيه يكون تأويلا لا تصرفا في الحديث.
وكذلك قال الشافعي رحمه الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال: من بدل دينه فاقتلوه ثم قد ظهر من فتوى ابن عباس أن المرتدة لا تقتل فقال: هذا تخصيص لحق الحديث من الراوي وذلك بمنزلة التأويل لا يكون حجة على غيره، فأنا آخذ بظاهر الحديث وأوجب القتل على المرتدة.
وأما ترك العمل بالحديث أصلا فهو بمنزلة العمل بخلاف الحديث حتى يخرج به من أن يكون حجة، لان ترك العمل بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام كما أن العمل بخلافه حرام، ومن هذا النوع ترك ابن عمر العمل بحديث رفع اليدين عند الركوع كما بينا.
وأما ما يكون من جهة غير الراوي فهو قسمان: أحدهما ما يكون من جهة الصحابة، والثاني ما يكون من جهة أئمة الحديث.
فأما ما يكون من الصحابة فهو
نوعان على ما ذكره عيسى بن أبان رحمه الله: أحدهما أن يعمل بخلاف الحديث بعض الائمة من الصحابة وهو ممن يعلم أنه لا يخفى عليه مثل ذلك الحديث، فيخرج الحديث به من أن يكون حجة، لانه لما انقطع توهم أنه لم يبلغه ولا يظن به مخالفة حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء رواه هو أو غيره، فأحسن الوجوه فيه أنه علم انتساخه أو أن ذلك الحكم لم يكن حتما فيجب حمله على هذا.
وبيانه فيما روى البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ثم صح عن الخلفاء أنهم أبوا الجمع بين الجلد والرجم بعد علمنا أنه لم يخف عليهم الحديث لشهرته، فعرفنا به انتساخ هذا الحكم، وكذلك صح عن عمر رضي الله عنه قوله: والله لا أنفي أحدا أبدا.
وقول علي رضي الله عنه: كفى بالنفي فتنة، مع علمنا أنه لم يخف عليهما الحديث، فاستدللنا به على انتساخ حكم الجمع بين الجلد والتغريب.
وكذلك ما يروى أن عمر رضي الله عنه حين فتح السواد من بها على أهلها وأبى أن يقسمها بين الغانمين مع علمنا أنه لم يخف عليه قسمة رسول الله عليه السلام خيبر بين أصحابه حين افتتحها، فاستدللنا به على أنه علم أن ذلك لم يكن حكما حتما من رسول الله عليه السلام على وجه لا يجوز غيره في الغنائم.
فإن قيل: أليس أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يطبق في الصلاة بعد ما ثبت انتساخه بحديث مشهور فيه أمر بالاخذ بالركب، ثم خفي عليه ذلك حتى لم يجعل عمله دليلا، على أن الحديث الذي فيه أمر بالاخذ بالركب منسوخ أو أن الاخذ بالركب لا يكون عينا في الصلاة ؟ قلنا: ما خفي على ابن مسعود حديث الامر بالاخذ بالركب، وإنما وقع عنده أنه على سبيل الرخصة فكان تلحقهم المشقة في التطبيق مع طول الركوع لانهم كانوا يخافون السقوط على الارض، فأمروا بالاخذ بالركب تيسيرا عليهم لا تعيينا عليهم، فلاجل هذا التأويل لم يترك العمل بظاهر الحديث
الذي فيه أمر بالاخذ بالركب.
والوجه الثاني أن يظهر منه العمل بخلاف الحديث وهو ممن يجوز أن يخفى عليه ذلك الحديث، فلا يخرج الحديث من أن يكون حجة بعمله بخلافه.
وبيان هذا فيما روي أن النبي عليه السلام رخص للحائض في أن تترك طواف الصدر، ثم صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها تقيم حتى تطهر فتطوف، ولا تترك بهذا العمل بالحديث الذي فيه رخصة لجواز أن يكون ذلك خفي عليه.
وكذلك ما يروى عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه أنه كان لا يوجب إعادة الوضوء على من قهقه في الصلاة، ولا يترك به العمل بالحديث الموجب للوضوء من القهقهة في الصلاة لجواز أن يكون ذلك خفي عليه.
وكذلك قول ابن عمر: لا يحج أحد عن أحد، لا يمنع العمل بالحديث الوارد في الاحجاج عن الشيخ الكبير لجواز أن يكون ذلك خفي عليه، وهذا لان الحديث معمول به إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يترك العمل به باعتبار عمل ممن هو دونه بخلافه، وإنما تحمل فتواه بخلاف الحديث على أحسن الوجهين وهو أنه إنما أفتى به برأيه، لانه خفي عليه النص ولو بلغه لرجع إليه فعلى من يبلغه الحديث بطريق صحيح أن يأخذ به.
وأما ما يكون من أئمة الحديث فهو الطعن في الرواة، وذلك نوعان: مبهم، ومفسر.
ثم المفسر نوعان: ما لا يصلح أن يكون طعنا، وما يصلح أن يكون.
والذي يصلح نوعان: مجتهد فيه، أو متفق عليه.
والمتفق عليه نوعان: أن يكون ممن هو مشهور بالنصيحة والاتقان، أو ممن هو معروف بالتعصب والعداوة.
فأما الطعن المبهم فهو عند الفقهاء لا يكون جرحا، لان العدالة باعتبار ظاهر الدين ثابت لكل مسلم خصوصا من كان من القرون الثلاثة، فلا يترك ذلك بطعن مبهم، ألا ترى أن الشهادة أضيق من رواية الخبر في هذا.
ثم الطعن المبهم من المدعى عليه لا يكون جرحا
فكذلك من المزكي، ولا يمتنع العمل بالشهادة لاجل الطعن المبهم، فلان لا يخرج الحديث بالطعن المبهم من أن يكون حجة أولى.
وهذا للعادة الظاهرة أن الانسان إذا لحقه من غير ما يسوءه فإنه يعجز عن إمساك لسانه في ذلك الوقت حتى يطعن فيه طعنا مبهما إلا من عصمه الله تعالى، ثم إذا طلب منه تفسير ذلك لا يكون له أصل.
والمفسر الذي لا يصلح أن يكون طعنا لا يوجب الجرح أيضا، وذلك مثل طعن بعض المتعنتين في أبي حنيفة أنه دس ابنه ليأخذ كتب أستاذه حماد فكان يروي من ذلك.
وهذا إن صح فهو لا يصلح طعنا بل هو دليل الاتقان فقد كان هو لا يستجيز الرواية إلا عن حفظ، والانسان لا يقوى اعتماده على جميع ما يحفظه، ففعل ذلك ليقابل حفظه بكتب أستاذه فيزداد به معنى الاتقان.
وكذلك الطعن بالتدليس على من يقول حدثني فلان عن فلان ولا يقول قال حدثني فلان فإن هذا لا يصلح أن يكون طعنا، لان هذا يوهم الارسال، وإذا كان حقيقة الارسال دليل زيادة الاتقان على ما بينا فما يوهم الارسال كيف يكون طعنا.
ومنه الطعن بالتلبيس على من يكنى عن الراوي ولا يذكر اسمه ولا نسبه، نحو رواية سفيان الثوري بقوله حدثنا أبو سعيد من غير بيان يعلم به أن هذا ثقة أو غير ثقة، ونحو رواية محمد بقوله أخبرنا الثقة من غير تفسير، فإن هذا محمول على أحسن الوجوه وهو صيانة الراوي من أن يطعن فيه (بعض) من لا يبالي وصيانة السامع من أن
يبتلى بالطعن في أحد من غير حجة، على أن من يكون مطعونا في بعض رواياته بسبب لا يوجب عموم الطعن فيه فذلك لا يمنع قبول روايته والعمل به فيما سوى ذلك نحو الكلبي وأمثاله.
ثم سفيان الثوري ممن لا يخفى حاله في الفقه والعدالة ولا يظن به إلا أحسن الوجوه.
وكذلك محمد بن الحسن فتحمل الكناية منهما عن الراوي على أنهما قصدا صيانته، وكيف يجعل ذلك طعنا والقول بأنه ثقة شهادة بالعدالة له ؟.
ومن ذلك أيضا طعن بعض الجهال في محمد بن الحسن بأنه سأل عبد الله بن المبارك رحمه الله أن يروي له أحاديث ليسمعها منه فأبى فلما قيل له في ذلك فقال: لا تعجبني أخلاقه.
فإن هذا إن صح لم يصلح أن يكون طعنا لان أخلاق الفقهاء لا توافق أخلاق الزهاد في كل وجع، فهم بمحل القدوة والزهاد بمحل العزلة، وقد يحسن في مقام العزلة ما يقبح في مقام القدوة أو على عكس ذلك، فكيف يصلح أن يكون هذا طعنا لو صح مع أنه غير صحيح، فقد روي عن ابن المبارك أنه قال لا بد أن يكون في كل زمان من يحيي به الله للناس دينهم ودنياهم.
فقيل له: من بهذه الصفة في هذا الزمان ؟ فقال: محمد بن الحسن.
فهذا يتبين أنه لا أصل لذلك الطعن.
ومن ذلك الطعن بركض الدواب، فإن ذلك من عمل الجهاد، لان السباق على الافراس والاقدام مشروع ليتقوى به المرء على الجهاد، فما يكون من جنسه مشروع لا يصلح أن يكون طعنا.
ومن ذلك الطعن بكثرة المزاح فإن ذلك مباح شرعا إذا لم يتكلم بما ليس بحق، على ما روي أن النبي عليه السلام كان يمازح ولا يقول إلا حقا.
ولكن هذا بشرط أن لا يكون متخبطا مجازفا يعتاد القصد إلى رفع الحجة والتلبيس به، ألا ترى إلى ما روي أن عليا رضي الله عنه كان به دعابة.
وقد ذكر ذلك عمر حين ذكر اسمه في الشورى ولم يذكره على وجه الطعن، فعرفنا أن عينه لا يكون طعنا.
ومن ذلك الطعن بحداثة سن الراوي، فإن كثيرا من الصحابة كانوا يروون في حداثة سنهم، منهم ابن عباس وابن عمر، ولكن هذا بشرط الاتقان عند التحمل
في الصغر، وعند الرواية بعد البلوغ، ولهذا أخذنا بحديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه في صدقة الفطر أنه نصف صاع من بر، ورجحنا حديثه على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في التقدير بصاع من بر، لان حديثه أحسن متنا،
فذلك دليل الاتقان، ووافقه رواية ابن عباس أيضا.
والشافعي أخذ بحديث النعمان إبن بشير رضي الله عنهما في إثبات حق الرجوع للوالد فيما يهب لولده، وقد روي أنه نحله أبوه غلاما وهو ابن سبع سنين، فعرفنا أن مثل هذا لا يكون طعنا عند الفقهاء.
ومن ذلك الطعن بأن رواية الاخبار ليست بعادة له، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ما اعتاد الرواية ولا يظن بأحد أنه يطعن في حديثه بهذا السبب، وقبل رسول الله شهادة الاعرابي على رؤية هلال رمضان، والاعرابي ما كان اعتاد الرواية، وقد كان في الصحابة من يمتنع من الرواية في عامة الاوقات، وفيهم من يشتغل بالرواية في عامة الاوقات، ثم لم يرجح أحد رواية من اعتاد ذلك على من لم يعتد الرواية، وهذا لان المعتبر هو الاتقان، وربما يكون إتقان من لم تصر الرواية عادة له فيما يروي أكثر من إتقان من اعتاد الرواية.
ومن ذلك الطعن بالاستكثار من تفريع مسائل الفقه، فإن ذلك دليل الاجتهاد وقوة الخاطر، فيستدل به على حسن الضبط والاتقان، فكيف يصلح أن يكون طعنا وما يكون مجتهدا فيه الطعن بالارسال ؟ وقد بينا أنه ليس بطعن عندنا لانه دليل تأكد الخبر وإتقان الراوي في السماع من غير واحد.
وأما الطعن المفسر بما يكون موجبا للجرح، فإن حصل ممن هو معروف بالتعصب أو متهم به لظهور سبب باعث له على العداوة فإنه لا يوجب الجرح، وذلك نحو طعن الملحدين والمتهمين ببعض الاهواء المضلة في أهل السنة، وطعن بعض من ينتحل مذهب الشافعي رحمه الله في بعض المتقدمين من كبار أصحابنا، فإنه لا يوجب الجرح لعلمنا أنه كان عن تعصب وعداوة.
فأما وجوه الطعن الموجب للجرح فربما ينتهي إلى أربعين وجها يطول الكتاب بذكر تلك الوجوه، ومن طلبها في كتاب الجرح والتعديل وقف عليها إن شاء الله تعالى.
فصل: في بيان المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها وشرطها قال رضي الله عنه: اعلم بأن الحجج الشرعية من الكتاب والسنة لا يقع بينهما التعارض والتناقض وضعا، لان ذلك من أمارات العجز والله يتعالى عن أن يوصف به، وإنما يقع التعارض لجهلنا بالتاريخ، فإنه يتعذر به علينا التمييز بين الناسخ والمنسوخ، ألا ترى أن عند العلم بالتاريخ لا تقع المعارضة بوجه ولكن المتأخر ناسخ للمتقدم، فعرفنا أن الواجب في الاصل طلب التاريخ ليعلم به الناسخ من المنسوخ، وإذا لم يوجد ذلك يقع التعارض بينهما في حقنا من غير أن يتمكن التعارض فيما هو حكم الله تعالى في الحادثة، ولاجل هذا يحتاج إلى معرفة تفسير المعارضة، وركنها، وشرطها، وحكمها.
فأما التفسير: فهي الممانعة على سبيل المقابلة.
يقال: عرض لي كذا: أي استقبلني فمنعني مما قصدته، ومنه سميت الموانع عوارض، فإذا تقابل الحجتان على سبيل المدافعة والممانعة سميت معارضة.
وأما الركن: فهو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجبه الاخرى، كالحل والحرمة والنفي والاثبات، لان ركن الشئ ما يقوم به ذلك الشئ، وبالحجتين المتساويتين تقوم المقابلة إذا لا مقابلة للضعيف مع القوي.
وأما الشرط: فهو أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد وفي محل واحد، لان المضادة والتنافي لا يتحقق بين الشيئين في وقتين ولا في محلين حسا وحكما.
ومن الحسيات الليل والنهار لا يتصور اجتماعهما في وقت واحد، ويجوز أن يكون بعض الزمان نهارا والبعض ليلا، وكذلك السواد مع البياض مجتمعان في العين في محلين ولا تصور لاجتماعهما في محل واحد.
ومن الحكميات النكاح فإنه يوجب الحل
في المنكوحة والحرمة في أمها وبنتها، ولا يتحقق التضاد بينهما في محلين حتى صح إثباتهما بسبب واحد.
والصوم يجب في وقت والفطر في وقت آخر ولا يتحقق
معنى التضاد بينهما باختلاف الوقت، فعرفنا أن شرط التضاد والتمانع اتحاد المحل والوقت.
ومن الشرط أن يكون كل واحد منهما موجبا على وجه يجوز أن يكون ناسخا للآخر إذا عرف التاريخ بينهما، ولهذا قلنا: يقع التعارض بين الآيتين، وبين القراءتين، وبين السنتين، وبين الآية والسنة المشهورة، لان كل واحد منهما يجوز أن يكون ناسخا إذا علم التاريخ بينهما، على ما نبينه في باب النسخ.
ولا يقع التعارض بين القياسين، لان أحدهما لا يجوز أن يكون ناسخا للآخر، فإن النسخ لا يكون إلا فيما هو موجب للعلم والقياس لا يوجب ذلك ولا يكون ذلك إلا عن تاريخ وذلك لا يتحقق في القياسين.
وكذلك لا يقع التعارض في أقاويل الصحابة لان كل واحد منهما (إنما) قال ذلك عن رأيه والرواية لا تثبت بالاحتمال، وكما أن الرأيين من واحد لا يصلح أن يكون أحدهما ناسخا للآخر فكذلك من اثنين.
وأما الحكم فنقول: متى وقع التعارض بين الآيتين فالسبيل الرجوع إلى سبب النزول ليعلم التاريخ بينهما، فإذا علم ذلك كان المتأخر ناسخا للمتقدم فيجب العمل بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ، فإن لم يعلم ذلك فحينئذ يجب المصير إلى السنة لمعرفة حكم الحادثة، ويجب العمل بذلك إن وجد في السنة، لان المعارضة لما تحققت في حقنا فقد تعذر علينا العمل بالآيتين، إذ ليست إحداهما بالعمل بها أولى من الاخرى والتحقق بما لو لم يوجد حكم الحادثة في الكتاب فيجب المصير إلى السنة في معرفة الحكم.
وكذلك إن وقع التعارض بين السنتين ولم يعرف التاريخ فإنه يصار إلى ما بعد السنة فيما يكون حجة في حكم الحادثة، وذلك قول الصحابي أو القياس
الصحيح على ما بينا من قبل في الترتيب في الحجج الشرعية، لان عند المعارضة يتعذر العمل بالمتعارضين، ففي حكم العمل يجعل ذلك كالمعدوم أصلا.
وعلى هذا قلنا: إذا ادعى رجلان نكاح امرأة وأقام كل واحد منهما البينة وتعذر ترجيح إحدى البينتين بوجه من الوجوه فإنه تبطل الحجتان ويصير كأنه لم يقم كل واحد منهما البينة.
فأما إذا وقع التعارض بين القياسين، فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر بدليل شرعي وذلك قوة في أحدهما لا يوجد مثله في الآخر يجب العمل بالراجح ويكون ذلك بمنزلة معرفة التاريخ في النصوص، وإن لم يوجد ذلك فإن المجتهد يعمل بأيهما شاء لا باعتبار أن كل واحد منهما حق أو صواب، فالحق أحدهما والآخر خطأ على ما هو المذهب عندنا في المجتهد أنه يصيب تارة ويخطئ أخرى، ولكنه معذور في العمل به في الظاهر ما لم يتبين له الخطأ بدليل أقوى من ذلك، وهذا لانه في طريق الاجتهاد مصيب، وإن لم يقف على الصواب باجتهاده وطمأنينة القلب إلى ما أدى إليه اجتهاده يصلح أن يكون دليلا في حكم العمل شرعا عند تحقق الضرورة بانقطاع الادلة.
قال عليه السلام: المؤمن ينظر بنور الله وقال: فراسة المؤمن لا تخطئ ولهذا جوزنا التحري في باب القبلة عند انقطاع الادلة الدالة على الجهة، وحكمنا بجواز الصلاة سواء تبين أنه أصاب جهة الكعبة أو أخطأ، لانه اعتمد في عمله دليلا شرعيا، وإليه أشار علي رضي الله عنه بقوله: قبلة المتحري جهة قصده.
وإنما جعلناه مخيرا عند تعارض القياسين لاجل الضرورة، لانه إن ترك العمل بهما للتعارض احتاج إلى اعتبار الحال لبناء حكم الحادثة عليه، إذ ليس بعد القياس دليل شرعي يرجع إليه في معرفة حكم الحادثة، والعمل بالحال عمل بلا دليل، ولا إشكال أن العمل بدليل شرعي فيه احتمال الخطأ والصواب يكون أولى من العمل بلا دليل، ولكن هذه
الضرورة إنما تتحقق في القياسين ولا تتحقق في النصين لانه يترتب عليهما دليل شرعي يرجع إليه في معرفة حكم الحادثة، لهذا لا يتخير هناك في العمل بأي النصين شاء.
وعلى هذا الاصل قلنا: إذا كان في السفر ومعه إناءان في أحدهما ماء طاهر وفي الآخر ماء نجس ولا يعرف الطاهر من النجس، فإنه يتحرى للشرب ولا يتحرى للوضوء بل يتيمم، لان في حق الشرب لا يجد بدلا يصير إليه في تحصيل مقصوده، فله أن يصير إلى التحري لتحقق الضرورة، وفي حكم الطهارة يجد شيئا آخر يطهر به عند العجز عن استعمال الماء الطاهر وهو التيمم فلا يتحقق فيه الضرورة، وبسبب المعارضة يجعل لعادم الماء فيصير إلى التيمم، وقلنا في المساليخ إذا استوت الذكية والميتة ففي حالة الضرورة بأن لم يجد حلالا سوى ذلك جاز له التحري، وعند عدم الضرورة بوجود طعام حلال لا يكون له أن يصير إلى التحري، ولهذا
لم يجوز التحري في الفروج أصلا عند اختلاط المعتقة عينا بغير المعتقة، لان جواز ذلك باعتبار الضرورة ولا مدخل للضرورة في إباحة الفرج بدون الملك بخلاف الطعام والشراب.
ثم إذا عمل بأحد القياسين وحكم بصحة عمله باعتبار الظاهر يصير ذلك لازما له حتى لا يجوز له أن يتركه ويعمل بالآخر من غير دليل موجب لذلك.
وعلى هذا قلنا في الثوبين: إذا كان أحدهما طاهرا والآخر نجسا وهو لا يجد ثوبا آخر فإنه يصير إلى التحري لتحقق الضرورة، فإنه لو ترك لبسهما لا يجد شيئا آخر يقيم به فرض الستر الذي هو شرط جواز الصلاة، وبعدما صلى في أحد الثوبين بالتحري لا يكون له أن يصلي في الثوب الآخر، لانا حين حكمنا بجواز الصلاة في ذلك الثوب فذلك دليل شرعي موجب طهارة ذلك الثوب، والحكم بنجاسة الثوب الآخر فلا تجوز الصلاة فيه بعد ذلك إلا بدليل أقوى منه.
فإن قيل: أليس أنه لو تحرى عند اشتباه القبلة وصلى صلاة إلى جهة ثم وقع تحريه
على جهة أخرى يجوز له أن يصلي في المستقبل إلى الجهة الثانية، ولم يجعل ذلك دليلا على أن جهة القبلة ما أدى إليه اجتهاده في الابتداء ؟ قلنا: لان هناك الحكم بجواز الصلاة إلى تلك الجهة لا يتضمن الحكم بكونها جهة الكعبة لا محالة، ألا ترى أنه وإن تبين له الخطأ بيقين بأن استدبر الكعبة جازت صلاته، وفي الثوب من ضرورة الحكم بجواز الصلاة في ثوب الحكم بطهارة ذلك الثوب، حتى إذا تبين أنه كان نجسا تلزمه إعادة الصلاة، والعمل بالقياس من هذا القبيل، فإن صحة العمل بأحد القياسين يتضمن الحكم بكونه حجة للعمل به ظاهرا، ولهذا لو تبين نص بخلافه بطل حكم العمل به، فلهذا كان العمل بأحد القياسين مانعا له من العمل بالقياس الآخر بعد ما لم يتبين دليل أقوى منه.
ووجه آخر أن التعارض بين النصين إنما يقع لجهلنا بالتاريخ بينهما والجهل لا يصلح دليلا على حكم شرعي من حيث العلم لا من حيث العمل، والاختيار حكم شرعي لا يجوز أن يثبت باعتبار هذا الجهل.
فأما التعارض بين القياسين باعتبار كون كل واحد منهما صالحا للعمل به في أصل الوضع وإن كان أحدهما صوابا حقيقة والآخر خطأ، ولكن من حيث الظاهر هو معمول
به شرعا ما لم يتبين وجه الخطأ فيه، فإثبات الخيار بينهما في حكم العمل إذا رجح أحدهما بنوع فراسة يكون إثبات الحكم بدليل شرعي، ثم إذا عمل بأحدهما صح ذلك بالاجماع فلا يكون له أن ينقض ما نفذ من القضاء منه بالاجماع، ولا يصير إلى العمل بالآخر إلا بدليل هو أقوى من الاول.
فإن قيل: لو ثبت الخيار له في العمل بالقياسين لكان يبقى خياره بعدما عمل بأحدهما في حادثة حتى يكون له أن يعمل بالآخر في حادثة أخرى كما في كفارة اليمين، فإنه لو عين أحد الانواع في تكفير يمين به يبقى خياره في تعيين نوع آخر في كفارة يمين أخرى.
قلنا: هناك التخيير ثبت على أن كل واحد من الانواع صالح للتكفير
به بدليل موجب للعلم، وهنا الخيار ما ثبت بمثل هذا الدليل بل باعتبار أن كل واحد منهما صالح للعمل به ظاهرا، مع علمنا بأن الحق أحدهما والآخر خطأ، فبعد ما تأيد أحدهما بنفوذ القضاء به لا يكون له أن يصير إلى الآخر إلا بدليل هو أقوى من الاول، وهذا لان جهة الصواب تترجح بعمله فيما عمل به، ومن ضرورته ترجح جانب الخطأ في الآخر ظاهرا، فما لم يرتفع ذلك بدليل سوى ما كان موجودا عند العمل بأحدهما لا يكون له أن يصير إلى العمل بالآخر.
والحاصل: أن فيما ليس فيه احتمال الانتقال من محل إلى محل إذا تعين المحل بعمله لا يبقى له خيار بعد ذلك كالنجاسة في الثوب، فإنها لا تحتمل الانتقال من ثوب إلى ثوب، فإذا تعين بصلاته في أحد الثوبين صفة الطهارة فيه والنجاسة في الآخر لا يبقى له رأي في الصلاة في الثوب الآخر ما لم يثبت طهارته بدليل موجب للعلم.
وفي باب القبلة فرض التوجه يحتمل الانتقال، ألا ترى أنه انتقل من بيت المقدس إلى الكعبة، ومن عين الكعبة إلى الجهة إذا بعد من مكة، ومن جهة الكعبة إلى سائر الجهات إذا كان راكبا فإنه يصلي حيثما توجهت به راحلته، فبعد ما صلى بالتحري إلى جهة إذا تحول رأيه ينتقل فرض التوجه إلى تلك الجهة أيضا، لان الشرط أن يكون مبتلى في التوجه عند القيام إلى الصلاة، وإنما يتحقق هذا إذا صلى إلى الجهة التي وقع عليها تحريه.
وكذلك حكم العمل بالقياس في المجتهدات فإن القضاء الذي نفذ بالقياس في محل لا يحتمل الانتقال إلى محل آخر فيلزم ذلك.
فأما
فيما وراء ذلك الحكم محتمل للانتقال، فإن الكلام في حكم يحتمل النسخ، وشرط العمل بالقياس أن يكون مبتلى بطلب الطريق باعتبار أصل الوضع شرعا، فإذا استقر رأيه على أن الصواب هو الآخر كان عليه أن يعمل في المستقبل.
وعلى هذا الاصل قلنا: إذا طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم نسي أو أعتق أحد المملوكين
بعينه ثم نسي لا يثبت له خيار البيان، لان الواقع من الطلاق والعتاق لا يحتمل الانتقال من محل إلى محل آخر، وإنما ثبتت المعارضة بين المحلين في حقه لجهله بالمحل الذي عينه عند الايقاع وجهله لا يثبت الخيار له شرعا، وبمثله لو أوجب في أحدهما بغير عينه ابتداء كان له الخيار في البيان، لان تعيين المحل كان مملوكا له شرعا كابتداء الايقاع، ولكنه بمباشرة الايقاع أسقط ما كان له من الخيار في أصل الايقاع، ولم يسقط ما كان له من الخيار في التعيين فيبقى ذلك الخيار ثابتا له شرعا، ومما يثبت فيه حكم التعارض سؤر الحمار والبغل، فقد تعارضت الادلة في الحكم بطهارته ونجاسته، وقد بينا هذا في فروع الفقه، ولكن لا يمكن المصير إلى القياس بعد هذا التعارض، لان القياس لا يصلح لنصب الحكم به ابتداء فوجب العمل بدليل فيه بحسب الامكان وهو المصير إلى الحال، فإن الماء كان طاهرا في الاصل فيبقى طاهرا.
نص عليه في غير موضع من النوادر، حتى قال: لو غمس الثوب في سؤر الحمار تجوز الصلاة فيه ولا يتنجس العضو أيضا باستعماله، لانه عرق طاهر في الاصل.
وهذا الدليل لا يصلح أن يكون مطلقا أداء الصلاة به وحده، لان الحدث كان ثابتا قبل استعماله فلا يزول باستعماله بيقين، فشرطنا ضم التيمم إليه حتى يحصل التيقن بالطهارة المطلقة لاداء الصلاة.
وكذلك الخنثى إذا لم يظهر فيه دليل يترجح به صفة الذكورة أو الانوثة فإنه يكون مشكل الحال يجعل بمنزلة الذكور في بعض الاحكام وبمنزلة الاناث في البعض، على حسب ما يدل عليه الحال في كل حكم.
وكذلك المفقود فإنه يجعل بمنزله الحي في مال نفسه حتى لا يورث عنه وبمنزلة الميت في الارث من الغير، لان أمره مشكل فوجب المصير إلى الحال لاجل الضرورة والحكم بما يدل عليه الحال في كل حادثة.
وأما بيان المخلص عن المعارضات فنقول: يطلب هذا المخلص أولا من نفس
الحجة، فإن لم يوجد فمن الحكم، فإن لم يوجد فباعتبار الحال، فإن لم يوجد فبمعرفة التاريخ نصا، فإن لم يوجد فبدلالة التاريخ.
فأما الوجه الاول وهو الطلب المخلص من نفس الحجة فبيانه من أوجه: أحدها أن يكون أحد النصين محكما والآخر مجملا أو مشكلا، فإن بهذا يتبين أن التعارض حقيقة غير موجود بين النصين وإن كان موجودا ظاهرا فيصار إلى العمل بالحكم دون المجمل والمشكل.
وكذلك إن كان أحدهما نصا من الكتاب أو السنة المشهورة والآخر خبر الواحد.
وكذلك إن كان أحدهما محتملا للخصوص فإنه ينتفي معنى التعارض بتخصيصه بالنص الآخر.
وبيانه من الكتاب في قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقوله تعالى في المستأمن: (ثم أبلغه مأمنه) فإن التعارض يقع بين النصين ظاهرا ولكن قوله: (فاقطعوا أيديهما) عام يحتمل الخصوص فجعلنا قوله تعالى: (ثم أبلغه مأمنه) دليل تخصيص المستأمن من ذلك.
ومن السنة قوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ونهيه عن الصلاة في ثلاث ساعات، فالتعارض بين النصين ثبت ظاهرا ولكن قوله عليه السلام: فليصلها إذا ذكرها بعرض التخصيص فيجعل النص الآخر دليل التخصيص حتى ينتفي به التعارض.
وكذلك إن ظهر عمل الناس بأحد النصين دون الآخر، لان الذي ظهر العمل به بين الناس ترجح بدليل الاجماع فينتفي به معنى التعارض بينهما، مع أن الظاهر أن اتفاقهم على العمل به لكونه متأخرا ناسخا لما كان قبله، وبالعلم بالتاريخ ينتفي التعارض فكذلك بالاجماع الدال عليه، وإن كان المعمول به سابقا فذلك دليل على أن الآخر مؤول أو سهو من بعض الرواة إن كان في الاخبار، لان المنسوخ إذا اشتهر فناسخه يشتهر بعده أيضا، كما اشتهر تحريم المتعة بعد الاباحة واشتهر إباحة زيارة القبور وإمساك لحوم الاضاحي والشرب في الاواني بعد النهي،
ولو اشتهر الناسخ لما أجمعوا على العمل بخلافه، فبهذا الطريق تنتفي المعارضة وكما ينتفي التعارض بدليل الاجماع يثبت التعارض بدليل الاجماع فإن النبي عليه السلام سئل عن ميراث العمة والخالة فقال: لا شئ لهما وقال: الخال وارث من لا وارث له فمن حيث الظاهر لا تعارض بين الحديثين، لان كل واحد منهما في محل آخر ولكن ثبت بإجماع الناس أنه لا فرق بين الخال والخالة والعمة في صفة الوراثة، فباعتبار هذا الاجماع يقع التعارض بين النصين، ثم رجح علماؤنا المثبت منهما، ورجح الشافعي ما كان معلوما باعتبار الاصل وهو عدم استحقاق الميراث.
وبيان الطلب المخلص من حيث الحكم أن التعارض إنما يقع للمدافعة بين الحكمين، فإن كان الحكم الثابت بأحد النصين مدفوعا بالآخر لا محالة فهو التعارض حقيقة، وإن أمكن إثبات حكم بكل واحد من النصين سوى الحكم الآخر لا تتحقق المدافعة فينتفي التعارض.
وبيان ذلك في قوله تعالى (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) مع قوله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) فبين النصين تعارض من حيث الظاهر في يمين الغموس فإنها من كسب القلوب، ولكنها غير معقودة لانها لم تصادف محل عقد اليمين وهو الخبر الذي فيه رجاء الصدق، ولكن انتفى هذا التعارض باعتبار الحكم فإن المؤاخذة المذكورة في قوله تعالى: (بما عقدتم الايمان) هي المؤاخذة بالكفارة في الدنيا، وفي قوله تعالى: (بما كسبت قلوبكم) المؤاخذة بالعقوبة في الآخرة، لانه أطلق المؤاخذة فيها والمؤاخذة المطلقة تكون في دار الجزاء فإن الجزاء بوفاق العمل، فأما في الدنيا فقد يبتلى المطيع ليكون تمحيصا لذنوبه وينعم على العاصي استدراجا، فبهذا الطريق تبين أن الحكم الثابت في أحد النصين غير الحكم الثابت في الآخر، وإذا انتفت المدافعة بين الحكمين ظهر المخلص عن التعارض.
فأما المخلص بطريق الحال فبيانه في قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن)
بالتخفيف في إحدى القراءتين وبالتشديد في الاخرى، فبينهما تعارض في الظاهر، لان حتى للغاية وبين امتداد الشئ إلى غاية وبين قصوره دونها منافاة، والاطهار هو الاغتسال والطهر يكون بانقطاع الدم فبين امتداد حرمة القربان إلى الاغتسال وبين ثبوت حل القربان عند انقطاع الدم منافاة، ولكن باعتبار الحال ينتفي هذا التعارض، وهو أن تحمل القراءة
بالتشديد على حال ما إذا كان أيامها دون العشرة، والقراءة بالتخفيف على حال ما إذا كان أيامها عشرة، لان الطهر بالانقطاع إنما يتيقن به في تلك الحالة، فإن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، فأما فيما دون العشرة لا يثبت الطهر بالانقطاع بيقين، لتوهم أن يعاودها الدم ويكون ذلك حيضا فتمتد حرمة القربان إلى الاطهار بالاغتسال.
وكذلك قوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين) فالتعارض يقع في الظاهر بين القراءة بالنصب الذي يجعل الرجل عطفا على المغسول، والقراءة بالخفض الذي يجعل الرجل عطفا على الممسوح (ثم) تنتفي هذه المعارضة بأن تحمل القراءة بالخفض على حال ما إذا كان لابسا للخف، بطريق أن الجلد الذي استتر به الرجل يجعل قائما مقام بشرة الرجل، فإنما ذكر الرجل عبارة عنه بهذا الطريق، والقراءة بالنصب على حال ظهور القدم، فإن الفرض في هذه الحالة غسل الرجلين عينا.
فأما طلب المخلص من حيث التاريخ فهو أن يعلم بالدليل التاريخ فيما بين النصين، فيكون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم.
وبيان هذا فيما قال ابن مسعود رضي الله عنه في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا محتجا به على من يقول إنها تعتد بأبعد الاجلين، فإنه قال: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى: (وأولات الاحمال أجلهن) نزلت بعد سورة النساء الطولى: (يتربصن بأنفسهن) فجعل التأخر دليل النسخ، فعرفنا أنه كان معروفا فيما بينهم أن المتأخر من النصين ناسخ للمتقدم.
فأما طلب المخلص بدلالة التاريخ وهو أن يكون أحد النصين موجبا للحظر
والآخر موجبا للاباحة نحو ما روي أن النبي عليه السلام نهى عن أكل الضب وروي أنه رخص فيه، وما روي أنه عليه السلام نهى عن أكل الضبع وروي أنه عليه السلام رخص فيه، فإن التعارض بين النصين ثابت من حيث الظاهر ثم ينتفي ذلك بالمصير إلى دلالة التاريخ وهو أن النص الموجب للحظر يكون متأخرا عن الموجب للاباحة فكان الاخذ به أولى.
وبيان ذلك وهو أن الموجب للاباحة يبقى ما كان على ما كان على طريقة بعض مشايخنا، لكون الاباحة أصلا في الاشياء، كما أشار إليه محمد في كتاب الاكراه، وعلى أقوى الطريقين باعتبار أن قبل مبعث
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الاباحة ظاهرة في هذه الاشياء، فإن الناس لم يتركوا سدى في شئ من الاوقات، ولكن في زمان الفترة الاباحة كانت ظاهرة في الناس وذلك باق إلى أن ثبت الدليل الموجب للحرمة في شريعتنا، فبهذا الوجه يتبين أن الموجب للحظر متأخر، وهذا لانا لو جعلنا الموجب للاباحة متأخرا احتجنا إلى إثبات نسخين: نسخ الاباحة الثابتة في الابتداء بالنص الموجب للحظر، ثم نسخ الحظر بالنص الموجب للاباحة، وإذا جعلنا نص الحظر متأخرا احتجنا إلى إثبات النسخ في أحدهما خاصة فكان هذا الجانب أولى، ولانه قد ثبت بالاتفاق نسخ حكم الاباحة بالحظر.
وأما نسخ حكم الحظر بالاباحة فمحتمل فبالاحتمال لا يثبت النسخ، ولان النص الموجب للحظر فيه زيادة حكم وهو نيل الثواب بالانتهاء عنه واستحقاق العقاب بالاقدام عليه، وذلك ينعدم في النص الموجب للاباحة، فكان تمام الاحتياط في إثبات التاريخ بينهما على أن يكون الموجب للحظر متأخرا والاخذ بالاحتياط أصل في الشرع.
واختلف مشايخنا فيما إذا كان أحد النصين موجبا للنفي والآخر موجبا للاثبات، فكان الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: المثبت أولى من النافي، لان
المثبت أقرب إلى الصدق من النافي ولهذا قبلت الشهادة على الاثبات دون النفي.
وكان عيسى بن أبان رحمه الله يقول: تتحقق المعارضة بينهما، لان الخبر الموجب للنفي معمول به كالموجب للاثبات، وما يستدل به على صدق الراوي في الخبر الموجب للاثبات فإنه يستدل بعينه على صدق الراوي في الخبر الموجب للنفي.
واختلف عمل المتقدمين من مشايخنا في مثل هذين النصين، فإنه روي أن رسول الله عليه السلام تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، وروي أنه تزوجها وهو حلال، ثم أخذنا برواية من روى أنه تزوجها وهو محرم والاثبات في الرواية الاخرى، لانهم اتفقوا أن العقد كان بعد إحرامه، فمن روى أنه تزوجها وهو حلال فهو المثبت للتحلل من الاحرام قبل العقد ثم لم يرجح المثبت على النافي هنا.
وروي أن بريرة أعتقت وزوجها كان حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروي أنها أعتقت وزوجها عبد، ولا خلاف أن زوجها كان عبدا في الاصل، فكان الاثبات في رواية من روى أن زوجها كان حرا حين أعتقت فأخذنا بذلك، فهذا يدل على أن الترجيح
يحصل بالاثبات.
وروي أن النبي عليه السلام رد ابنته زينب على أبي العاص رضي الله عنهما بنكاح جديد، وروي أنه ردها عليه بالنكاح الاول، والاثبات في رواية من روى أنه ردها عليه بعقد جديد، وبذلك أخذنا، فهو دليل على أن الترجيح يحصل بالاثبات.
وذكر في كتاب الاستحسان: إذا أخبر عدل بطهارة الماء وعدل آخر بنجاسته فإنه يتعارض الخبران والاثبات في خبر من أخبر بنجاسته ثم لم يرجح الخبر به.
وقال في التزكية: الشاهد إذا عدله واحد وجرحه آخر فإن الجرح يكون أولى لان في خبره إثباتا.
فإذا تبين من أصول علمائنا هذا كله فلا بد من طلب وجه يحصل به التوفيق بين هذه الفصول ويستمر المذهب عليه مستقيما.
وذلك الوجه أن خبر النفي إما أن يكون لدليل يوجب
العلم به أو لعدم الدليل المثبت أو يكون مشتبها، فإن كان لدليل يوجب العلم به فهو مساو للمثبت وتتحقق المعارضة بينهما، وعلى هذا قال في السير الكبير: إذا قالت المرأة سمعت زوجي يقول المسيح ابن الله فبنت منه، وقال الزوج إنما قلت المسيح ابن الله قول النصارى، أو وقالت النصارى المسيح ابن الله، فالقول قوله، فإن شهد للمرأة شاهدان.
وقالا لم نسمع من الزوج هذه الزيادة.
فالقول قوله أيضا، وإن قالا لم يقل هذه الزيادة قبلت الشهادة وفرق بينهما.
وكذا لو ادعى الاستثناء في الطلاق وشهد الشهود أنه لم يستثن قبلت الشهادة، وهذه شهادة على النفي ولكنها عن دليل موجب للعلم به وهو أن ما يكون من باب الكلام فهو مسموع من المتكلم لمن كان بالقرب منه، وما لم يسمع منه يكون دندنة لا كلاما، فإذا قبلت الشهادة على النفي إذا كان عن دليل كما تقبل على الاثبات قلنا في الخبر أيضا يقع التعارض بين النفي والاثبات.
فأما إذا كان خبر النفي لعدم العلم بالاثبات فإنه لا يكون معارضا للمثبت، لانه خبر لا عن دليل موجب بل عن استصحاب حال، وخبر المثبت عن دليل موجب له، ولان السامع والمخبر في هذا النوع سواء، فإن السامع غير عالم بالدليل المثبت كالمخبر بالنفي، فلو جاز أن يكون هذا
الخبر معارضا لخبر المثبت لجاز أن يكون علم السامع معارضا لخبر المثبت.
وإن كان الحال مشتبها فإنه يجب الرجوع إلى الخبر بالنفي واستفساره عما يخبر به ثم التأمل في كلامه، فإن ظهر أنه اعتمد في خبره دليلا موجبا العلم به فهو نظير القسم الاول، وإلا فهو نظير القسم الثاني.
ففي مسألة التزكية من يزكي الشاهد فقد عرفنا أنه إنما يزكيه لعدم العلم بسبب الجرح منه، إذ لا طريق لاحد إلى الوقوف على جميع أحوال غيره حتى يكون إخباره عن تزكيته عن دليل موجب العلم به، والذي جرحه فخبره مثبت الجرح العارض لوقوفه على دليل موجب له، فلهذا جعل خبره أولى.
وفي طهارة الماء ونجاسته
المخبر بالطهارة يعتمد دليلا، لانه توقف على طهارة الماء حقيقة فإن الماء الذي نزل من السماء إذا أخذه الانسان في إناء طاهر وكان بمرأى العين منه إلى وقت الاستعمال فإنه يعلم طهارته بدليل موجب له، كما أن المخبر بنجاسته يعتمد الدليل فتتحقق المعارضة بين الخبرين.
وعلى هذا أثبتنا المعارضة في حديث نكاح ميمونة لان المخبر بأنه كان محرما اعتمد دليلا، والمخبر بأنه كان حلالا اعتمد أيضا في خبره الدليل الموجب له، فإن هيئة المحرم ظاهرا يخالف هيئة الحلال فتتحقق المعارضة من هذا الوجه ويجب المصير إلى طلب الترجيح من جهة إتقان الراوي لما تعذر الترجيح من نفس الحجة، فأخذنا برواية ابن عباس رضي الله عنهما لانه روى القصة على وجهها وذلك دليل إتقانه، ولان يزيد بن الاصم لا يعادله في الضبط والاتقان.
وحديث رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص رجحنا فيه المثبت للنكاح الجديد، لان من نفى ذلك فهو لم يعتمد في نفيه دليلا موجبا العلم به بل عدم الدليل للاثبات وهو مشاهدة النكاح الجديد، فتبنى روايته على استصحاب الحال وهو أنه عرف النكاح بينهما فيما مضى وشاهد ردها عليه فروى أنه ردها بالنكاح الاول.
وفي حديث بريرة رجحنا الخبر المثبت لحرية الزوج عند عتقها، لان من يروي أنه كان عبدا فهو لم يعتمد في خبره دليلا موجبا لنفي الحرية، ولكن بنى خبره على استصحاب الحال لعدم علمه بدليل المثبت للحرية فلهذا رجحنا المثبت.
ومن هذا النوع رواية أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان قارنا في حجة الوداع، ورواية جابر رضي الله عنه أنه كان مفردا بالحج، فإنا رجحنا خبر المثبت للقران لان من روى الافراد
فهو ما اعتمد دليلا موجبا نفى القران ولكنه عدم الدليل الموجب للعلم به، وهو أنه لم يسمع تلبيته بالعمرة وسمع التلبية بالحج وروي أنه كان مفردا.
ومن ذلك حديث بلال رضي الله عنه أن النبي عليه السلام لم يصل في الكعبة،
مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى فيها عام الفتح، فإنهم اتفقوا أنه ما دخلها يومئذ إلا مرة، ومن أخبر أنه لم يصل فيها (فإنه) لم يعتمد دليلا موجبا للعلم به ولكنه لم يعاين صلاته فيها والآخر عاين ذلك فكان المثبت أولى من النافي.
ومن أهل النظر من يقول يتخلص عن التعارض بكثرة عدد الرواة حتى إذا كان أحد الخبرين يرويه واحد والآخر يرويه اثنان فالذي يرويه اثنان أولى بالعمل به.
واستدلوا بمسألة كتاب الاستحسان في الخبر بطهارة الماء ونجاسته وحل الطعام وحرمته، أنه إذا كان المخبر بأحد الامرين اثنين وبالآخر واحدا، فإنه يؤخذ بخبر الاثنين، وهذا لان خبر المثنى حجة تامة في الشهادات بخلاف خبر الواحد فطمأنينة القلب إلى خبر المثنى أكثر، وقد اشتهر عن الصحابة الاعتماد على خبر المثنى دون الواحد على ما سبق بيانه.
وكذلك يتخلص عن التعارض أيضا بحرية الراوي استدلالا بما ذكر في الاستحسان أنه متى كان المخبر بأحد الامرين حرين وبالآخر عبدين فإنه يؤخذ بخبر الحرين.
قال رضي الله عنه: والذي يصح عندي أن هذا النوع من الترجيح قول محمد رحمه الله خاصة، فقد ذكر نظيره في السير الكبير قال: أهل العلم بالسير ثلاث فرق: أهل الشام، وأهل الحجاز، وأهل العراق، فكل ما اتفق فيه الفريقان (منهم) على قول أخذت بذلك وتركت ما انفرد به فريق واحد.
وهذا ترجيح بكثرة القائلين صار إليه محمد، وأبى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف.
والصحيح ما قالا، فإن كثرة العدد لا يكون دليل قوة الحجة، قال تعالى: (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) وقال تعالى: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) وقال تعالى: (ما يعلمهم إلا قليل) وقال تعالى: (وقليل ما هم) ثم السلف من الصحابة وغيرهم لم يرجحوا بكثرة العدد في باب العمل بأخبار الآحاد فالقول به يكون
قولا بخلاف إجماعهم، ولما اتفقنا أن خبر الواحد موجب للعمل كخبر المثنى فيتحقق
التعارض بين الخبرين بناء على هذا الاجماع، أرأيت لو وصل إلى السامع أحد الخبرين بطرق والآخر بطريق واحد أكان يرجح ما وصل إليه بطرق إذا كان راوي الاصل واحدا، فهذا لا يقول به أحد، ولا يؤخذ حكم رواية الاخبار من حكم الشهادات، ألا ترى أن في رواية الاخبار يقع التعارض بين خبر المرأة وخبر الرجل، وبين خبر المحدود في القذف بعد التوبة وخبر غير المحدود، وبين خبر المثنى وخبر الاربعة وإن كان يظهر التفاوت بينهما في الشهادات حتى يثبت بشهادة الاربعة ما لا يثبت بشهادة الاثنين وهو الزنا.
وكذلك طمأنينة القلب إلى قول الاربعة أكثر ومع ذلك تتحقق المعارضة بين شهادة الاثنين وشهادة الاربعة في الاموال، ليعلم أنه لا يؤخذ حكم الحادثة من حادثة أخرى ما لم تعلم المساواة بينهما من كل وجه.
وإنما رجح خبر المثنى على خبر الواحد وخبر الحرين على خبر العبدين في مسألة الاستحسان لظهور الترجيح في العمل به فيما يرجع إلى حقوق العباد، فأما في أحكام الشرع فخبر الواحد وخبر المثنى في وجوب العمل به سواء.
ومن هذه الجملة إذا كان في أحد الخبرين زيادة لم تذكر تلك الزيادة في الخبر الثاني، فمذهبنا فيه أنه إذا كان الراوي واحدا يؤخذ بالمثبت للزيادة ويجعل حذف تلك الزيادة في بعض الطرق محالا على قلة ضبط الراوي وغفلته عن السماع، وذلك مثل ما يرويه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وفي رواية أخرى لم تذكر هذه الزيادة، فأخذنا بما فيه إثبات هذه الزيادة وقلنا لا يجري التحالف إلا عند قيام السلعة.
ومحمد والشافعي يقولان نعمل بالحديثين لان العمل بهما ممكن فلا نشتغل بترجيح أحدهما في العمل به.
والصحيح ما قلنا لوجهين: أحدهما أن أصل الخبر واحد وذلك متيقن به وكونهما خبرين محتمل وبالاحتمال لا يثبت الخبر، وإذا كان الخبر واحدا فحذف الزيادة من بعض الرواة ليس له طريق سوى ما قلنا.
والثاني أنا لو جعلناهما خبرين لم يكن للزيادة المذكورة في أحدهما فائدة فيما يرجع إلى بيان الحكم، لان الحكم واحد في الخبرين ولا يجوز حمل كلام رسول الله على ما فيه إخلاؤه عن الفائدة.
فأما إذا اختلف الراوي فقد علم أنهما خبران، وأن النبي
عليه السلام إنما قال كل واحد منهما في وقت آخر فيجب العمل بهما عند الامكان كما هو مذهبنا في أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين.
وبيان هذا فيما روي أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الطعام قبل القبض وقال لعتاب بن أسيد رضي الله عنه انههم عن أربعة: عن بيع ما لم يقبضوا فإنا نعمل بالحديثين ولا نجعل المطلق منهما محمولا على المقيد بالطعام حتى لا يجوز بيع سائر العروض قبل القبض كما لا يجوز بيع الطعام.
وأهل الحديث يجعلون الرواة في هذا طبقات فيقولون: إذا كانت الزيادة يرويها من هو في الطبقة العليا يجب الاخذ بذلك، وإن كانت الزيادة إنما يرويها من ليس في الطبقة العليا ويروي الخبر بدون الزيادة من هو في الطبقة العليا فإنه يثبت التعارض بينهما.
وكذلك قالوا في خبر يروى موقوفا على بعض الصحابة بطريق ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق، فإن كان يرويه عن رسول الله عليه السلام من هو في الطبقة العليا فإنه يثبت مرفوعا، وإن كان إنما يرويه عن رسول الله عليه السلام من ليس في الطبقة العليا ويرويه موقوفا من هو في الطبقة العليا فإنه يثبت موقوفا.
وكذلك قالوا في المسند والمرسل، ولكن الفقهاء لم يأخذوا بهذا القول، لان الترجيح عند أهل الفقه يكون بالحجة لا بأعيان الرجال، والله أعلم.
باب: البيان قال رضي الله عنه: اختلفت عبارة أصحابنا في معنى البيان.
قال أكثرهم: هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلا عما تستر به.
وقال بعضهم: هو ظهور
المراد للمخاطب والعلم بالامر الذي حصل له عند الخطاب، وهو اختيار أصحاب الشافعي، لان الرجل يقول: بان لي هذا المعنى بيانا: أي ظهر، وبانت المرأة من زوجها بينونة: أي حرمت، وبان الحبيب بينا: أي بعد، وكل ذلك عبارة عن الانفصال والظهور ولكنها بمعان مختلفة فاختلفت المصادر بحسبها.
والاصح هو الاول أن المراد هو الاظهار، فإن أحدا من العرب لا يفهم من إطلاق لفظ البيان العلم الواقع للمبين له، ولكن إذا قال الرجل: بين فلان كذا بيانا واضحا فإنما يفهم
منه أنه أظهره إظهارا لا يبقى معه شك، وإذا قيل: فلان ذو بيان فإنما يراد به الاظهار أيضا، وقول رسول الله: إن من البيان لسحرا يشهد لما قلنا إنه عبارة عن الاظهار، وقال تعالى: (هذا بيان للناس) وقال تعالى: (علمه البيان) والمراد الاظهار، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا بالبيان للناس، قال تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) وقد علمنا أنه بين للكل.
ومن وقع له العلم ببيانه أقر ومن لم يقع له العلم أصر.
ولو كان البيان عبارة عن العلم الواقع للمبين لما كان هو متمما للبيان في حق الناس كلهم.
وقول من يقول من أصحابنا حد البيان هو: الاخراج عن حد الاشكال إلى التجلي ليس بقوي، فإن هذا الحد أشكل من البيان والمقصود بذكر الحد زيادة كشف الشئ لا زيادة الاشكال فيه، ثم هذا الحد لبيان المجمل خاصة والبيان يكون فيه وفي غيره.
ثم المذهب عند الفقهاء وأكثر المتكلمين أن البيان يحصل بالفعل من رسول الله عليه السلام كما يحصل بالقول.
وقال بعض المتكلمين: لا يكون البيان إلا بالقول بناء على أصلهم أن بيان المجمل لا يكون إلا متصلا به، والفعل لا يكون متصلا بالقول.
فأما عندنا: بيان المجمل قد يكون متصلا به وقد يكون منفصلا عنه، على ما نبينه إن شاء الله تعالى.
ثم الدليل على أن البيان قد يحصل بالفعل أن جبريل عليه السلام بين مواقيت الصلاة للنبي عليه السلام بالفعل حيث أمه في البيت في اليومين، ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة قال للسائل: صل معنا ثم صلى في اليومين في وقتين، فبين له المواقيت بالفعل، وقال لاصحابه: خذوا عني مناسككم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي ففي هذا تنصيص على أن فعله مبين لهم، ولان البيان عبارة عن إظهار المراد فربما يكون ذلك بالفعل أبلغ منه بالقول، ألا ترى أنه أمر أصحابه بالحلق عام الحديبية فلم يفعلوا ثم لما رأوه حلق بنفسه حلقوا في الحال، فعرفنا أن إظهار المراد يحصل بالفعل كما يحصل بالقول.
ثم البيان على خمسة أوجه: بيان تقرير، وبيان تفسير، وبيان تغيير، وبيان تبديل، وبيان ضرورة.
فأما بيان التقرير: فهو في الحقيقة الذي يحتمل المجاز والعام المحتمل للخصوص، فيكون البيان قاطعا للاحتمال مقررا للحكم على ما اقتضاه الظاهر، وذلك نحو قوله تعالى: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) فصيغة الجمع تعم الملائكة على احتمال أن يكون المراد بعضهم، وقوله تعالى: (كلهم أجمعون) بيان قاطع لهذا الاحتمال فهو بيان التقرير.
وكذلك قوله تعالى: (ولا طائر يطير بجناحيه) يحتمل المجاز لان البريد يسمى طائرا فإذا قال يطير بجناحيه بين أنه أراد الحقيقة.
وهذا البيان صحيح موصولا كان أو مفصولا، لانه مقرر للحكم الثابت بالظاهر.
وعلى هذا قلنا: إذا قال لامرأته أنت طالق ثم قال نويت به الطلاق عن النكاح، أو قال لعبده أنت حر ثم قال نويت به الحرية عن الرق والملك، فإنه يكون ذلك بيانا صحيحا، لانه تقرير للحكم الثابت بظاهر الكلام لا تغيير له.
وأما بيان التفسير: فهو بيان المجمل والمشترك، فإن العمل بظاهره غير ممكن،
وإنما يوقف على المراد للعمل به بالبيان فيكون البيان تفسيرا له، وذلك نحو قوله تعالى: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ونظيره من مسائل الفقه إذا قال لامرأته أنت بائن أو أنت علي حرام، فإن البينونة والحرمة مشتركة فإذا قال عنيت به الطلاق كان هذا بيان تفسير، ثم بعد التفسير العمل بأصل الكلام، ولهذا أثبتنا به البينونة والحرمة.
وكذلك إذا قال لفلان علي ألف درهم وفي البلد نقود مختلفة ثم قال عنيت به نقد كذا، فإنه يكون ذلك بيان تفسير.
وسائر الكنايات في الطلاق والعتاق على هذا أيضا.
ثم هذا النوع يصح عند الفقهاء موصولا ومفصولا، وتأخير البيان عن أصل الكلام لا يخرجه من أن يكون بيانا، وعلى قول بعض المتكلمين لا يجوز تأخير بيان المجمل والمشترك عن أصل الكلام، لان بدون البيان لا يمكن العمل به والمقصود بالخطاب فهمه والعمل به، فإذا كان ذلك لا يحصل بدون البيان فلو جوزنا
تأخير البيان أدى إلى تكليف ما ليس في الوسع، يوضحه أنه لا يحسن خطاب العربي بلغة التركية ولا خطاب التركي بلغة العرب إذا علم أنه لا يفهم ذلك إلا أن يكون هناك ترجمان يبين له، وإنما لا يحسن ذلك لان المقصود بالخطاب إفهام السامع وهو لا يفهم فكذلك الخطاب بلفظ مجمل بدون بيان يقترن به لا يكون حسنا شرعا، لان المخاطب لا يفهم المراد به، وإنما يصح مع البيان لان المخاطب يفهم المراد به.
ولكنا نقول: الخطاب بالمجمل قبل البيان مفيد وهو الابتلاء باعتقاد الحقية فيما هو المراد به مع انتظار البيان للعمل به، وإنما يكون هذا تكليف ما ليس في الوسع أن لو أوجبنا العمل به قبل البيان ولا نوجب ذلك، ولكن الابتلاء باعتقاد الحقية فيه أهم من الابتلاء بالعمل به فكان حسنا صحيحا من هذا الوجه، ألا ترى أن الابتلاء بالمتشابه كان باعتقاد الحقية فيما هو المراد به من
غير انتظار البيان فلان يكون الابتلاء باعتقاد الحقية في المجمل مع انتظار البيان صحيحا كان أولى.
ومخاطبة العربي بلغ التركية تخلو عن هذه الفائدة، وإليه أشار الله في قوله تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) وبيان ما قلنا في قصة موسى عليه السلام مع معلمه فإنه كان مبتلى باعتقاد الحقية فيما فعله معلمه مع انتظار البيان، وما كان سؤاله في كل مرة إلا استعجالا منه للبيان الذي كان منتظرا له، ولهذا قال بعدما بينه له ما أخبر الله عن معلمه (ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا) .
ثم اختلف العلماء في جواز تأخير دليل الخصوص في العموم فقال علماؤنا رحمهم الله: دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم يكون بيانا، وإذا تأخر لم يكن بيانا بل يكون نسخا.
وقال الشافعي: يكون بيانا سواء كان متصلا بالعموم أو منفصلا عنه.
وإنما يبتنى هذا الخلاف على الاصل الذي قلنا إن مطلق العام عندنا يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا كالخاص، وعند الشافعي يوجب الحكم على احتمال الخصوص بمنزلة العام الذي ثبت خصوصه بالدليل فيكون دليل الخصوص على مذهبه فيهما بيان التفسير لا بيان التغيير فيصح موصولا ومفصولا.
وعندنا لما
كان العام المطلق موجبا للحكم قطعا فدليل الخصوص فيه يكون مغيرا لهذا الحكم، فإن العام الذي دخله خصوص لا يكون حكمه عندنا مثل حكم العام الذي لم يدخله خصوص، وبيان التغيير إنما يكون موصولا لا مفصولا على ما يأتيك بيانه إن شاء الله تعالى.
وعلى هذا قال علماؤنا: إذا أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفصه، فإن كان في كلام موصول فهو بيان وتكون الحلقة لاحدهما والفص للآخر، وإن كان في كلام مفصول فإنه لا يكون بيانا ولكن يكون إيجاب الفص للآخر ابتداء حتى يقع التعارض بينهما في الفص فتكون الحلقة للموصى له بالخاتم والفص بينهما نصفان.
وأما بيان
المجمل فليس بهذه الصفة بل هو بيان محض لوجود شرطه وهو كون اللفظ محتملا غير موجب للعمل به بنفسه، واحتمال كون البيان الملحق به تفسيرا وإعلاما لما هو المراد به، فيكون بيانا من كل وجه ولا يكون معارضا فيصح موصولا ومفصولا، ودليل الخصوص في العام ليس ببيان من كل وجه بل هو بيان من حيث احتمال صيغة العموم للخصوص، وهو ابتداء دليل معارض من حيث كون العام موجبا العمل بنفسه فيما تناوله، فيكون بمنزلة الاستثناء والشرط فيصح موصولا على أنه بيان، ويكون معارضا ناسخا للحكم الاول إذا كان مفصولا.
وقد بينا أدلة هذا الاصل الذي نشأ منه الخلاف، وإنما أعدناه هنا للحاجة إلى الجواب عن نصوص وشبه يحتج بها الخصم.
فمن ذلك قوله تعالى: (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) وثم للتعقيب مع التراخي فقد ضمن البيان بعد إلزام الاتباع وإلزام الاتباع إنما يكون بالعام دون المجمل، إذ المراد بالاتباع العمل به، فعرفنا أن البيان الذي هو خصوص قد يتأخر عن العموم.
وقال تعالى في قصة نوح عليه الصلاة والسلام: (قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك) وعموم اسم الاهل يتناول ابنه ولاجله كان سؤال نوح بقوله: (إن ابني من أهلي) ثم بين الله تعالى له بقوله تعالى: (إنه ليس من أهلك) وقال تعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ضيفه المكرمين: (إنا مهلكو أهل هذه القرية) وعموم هذا اللفظ يتناول لوطا ولهذا قال الخليل عليه السلام إن فيها لوطا، ثم بينوا له فقالوا (لننجينه وأهله) فدل أن دليل الخصوص يجوز أن ينفصل عن العموم.
وقال تعالى: (إنكم وما تعبدون من دون
الله حصب جهنم) ثم لما عارضه ابن الزبعري بعيسى والملائكة عليهم السلام نزل دليل الخصوص (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) والدليل عليه قصة بني إسرائيل فإنهم أمروا بذبح بقرة كما قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تذبحوا
بقرة) ثم لما استوصفوها بين لهم صفتها وكان ذلك دليل الخصوص على وجه البيان منفصلا عن أصل الخطاب.
والدليل عليه أن آية المواريث عامة في إيجاب الميراث للاقارب كفارا كانوا أو مسلمين، ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الارث يكون عند الموافقة في الدين لا عند المخالفة فيكون هذا تخصيصا منفصلا عن دليل العموم، وقوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) عام في تأخير الميراث عن الوصية في جميع المال، ثم بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوصية تختص بالثلث تخصيص منفصل عن دليل العموم فدل على أن ذلك جائز ولا يخرج به من أن يكون بيانا، واستدلوا بقوله تعالى: (ولذي القربى) فإنه عام تأخر بيان خصوصه إلى أن كلم عثمان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما رسول الله في ذلك فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب كشئ واحد وقال إنهم لم يفارقوني في الجاهلية ولا في الاسلام.
ثم قالوا تأخير البيان في الاعيان معتبر بتأخير البيان في الازمان وبالاتفاق يجوز أن يرد لفظ مطلقه يقتضي عموم الازمان ثم يتأخر عنه بيان أن المراد بعض الازمان دون البعض بالنسخ فكذلك يجوز أن يرد لفظ ظاهره يقتضي عموم الاعيان، ثم يتأخر عنه دليل الخصوص الذي يتبين به أن المراد بعض الاعيان دون البعض.
وحجتنا فيه أن الخصم يوافقنا بالقول في العموم وبطلان مذهب من يقول بالوقف في العموم، وقد أوضحنا ذلك بالدليل.
ثم من ضرورة القول بالعموم لزوم اعتقاد العموم فيه، والقول بجواز تأخير دليل الخصوص يؤدي إلى أن يقال يلزمنا اعتقاد الشئ على خلاف ما هو عليه وهذا في غاية الفساد.
وكما يجب اعتقاد العموم عند وجود صيغة العموم يجوز الاخبار به أيضا فيقال إنه عام.
وفي جواز تأخير البيان بدليل الخصوص يؤدي إلى القول بجواز الكذب في الحجج الشرعية وذلك باطل،