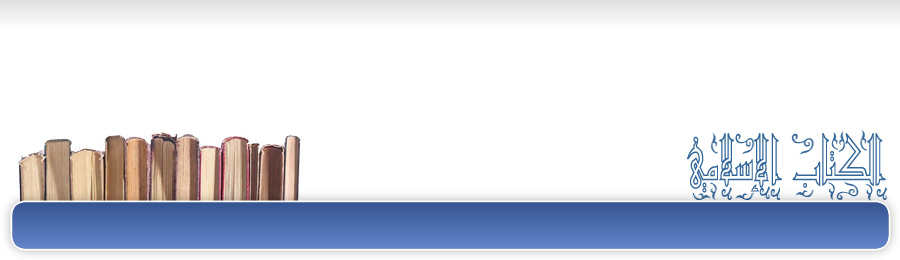الكتاب : أصول السرخسي
المؤلف : ابى بكر محمد بن احمد بن ابى سهل السرخسى
الاصل، وباعتبار صفة الحرمة زوال ملك الوطئ عن الحرة يعقب عدة موجبة براءة الرحم فلا تقع الحاجة إلى إقامة استحداث ملك الوطئ بالنكاح مقام حقيقة اشتغال الرحم في إيجاب الاستبراء للتحرز عن الخلط، وعلى هذا قلنا: إذا قال لامرأته أنت طالق الساعة إن كان في علم الله أن فلانا يقدم إلى شهر فقدم فلان بعد تمام الشهر يقع الطلاق عليها عند القدوم ابتداء، بمنزلة ما لو قال أنت طالق الساعة إن
قدم فلان إلى شهر ومعلوم أن بعد قدومه قد تبين أنه كان في علم الله قدومه إلى شهر وأن التعليق كان بشرط موجود حقيقة، ولكن لما لم يكن لنا طريق الوقوف عليه إلا بعد القدوم صار القدوم الذي به يتبين لنا شرطا لوقوع الطلاق (فيقع الطلاق) عنده ابتداء، بخلاف ما لو قال: أنت طالق الساعة إن كان زيد في الدار ثم علم بعد شهر أن زيدا في الدار يومئذ فإنه يكون الطلاق واقعا من حين تكلم به، لانه كان لنا طريق إلى الوقوف على ما جعله شرطا حقيقة فلا يقام ظهوره عندنا مقام حقيقته، ولكن تبين عند ظهوره أن الطلاق كان واقعا لانه علقه بشرط موجود، والذي تحقق ما ذكرنا أن صاحب الشرع خاطبنا بلسان العرب فإنما يفهم من خطاب الشرع ما يفهم من مخاطبات الناس فيما بينهم، ومن يقول لعبده أعط هذه المائة الدرهم هؤلاء بالسوية وهم مائة نفر نعلم قطعا أن مراده إعطاء كل واحد منهم درهما، بمنزلة ما لو قال أعط كل واحد منهم درهما، وكذلك يفهم من الخاص والعام في مخاطبات الشرع الحكم قطعا فيما تناوله كل واحد منهما.
ومن قال لغيره: لا تعتق عبدي سالما ثم قال أعتق البيض من عبيدي وسالم بهذه الصفة فإنه يكون له أن يعتقه وبإعتاقه يكون ممتثلا للامر لا مرتكبا للنهي، فكذلك نقول في العام المتأخر في خطاب الشرع إنه يكون قاضيا فيما تناوله على الخاص، فإذا كان حكم الخاص ثابتا قطعا فيما تناوله فلا بد من أن يكون العام كذلك ليكون قاضيا عليه.
فإن قيل: أليس أن تخصيص العام بالقياس وخبر الواحد جائز، ومعلوم أن القياس وخبر الواحد لا يوجب العلم قطعا فكيف يكون رافعا للحكم الثابت قطعا بصيغة
العموم إذا كانت هذه الصيغة توجب موجبها قطعا ؟ قلنا: مثل هذا يلزمك في الخاص فإن صرفه عن الحقيقة إلى المجاز بالقياس وخبر الواحد جائز.
ثم الجواب على ما اختاره أكثر مشايخنا رحمهم الله أن تخصيص العام الذي لم يثبت خصوصه ابتداء لا يجوز بالقياس (وخبر الواحد) وإنما يجوز ذلك في العام الذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم مثل ما يوجبه العام وهو خبر متأيد بالاستفاضة أو مشهور فيما بين السلف أو إجماع، فعند وجود ذلك يتبين بالقياس وخبر الواحد ما هو المراد بصيغة العام بعد أن خرج من أن يكون موجبا للحكم فيما يتناوله قطعا على ما نبينه في فصل العام إذا دخله خصوص، وهذا لان ما أوجبه القياس أو خبر الواحد يحتمل أن يكون في جملة ما تناوله دليل الخصوص ويحتمل أن يكون في جملة ما تناوله صيغة العام، فإنما يرجح بالقياس وخبر الواحد أحد الاحتمالين.
فإن قيل: ما ذهبت إليه أولى فإن الاصل هو وجوب العمل بالادلة الشرعية ما أمكن وذلك في ترتيب العام على الخاص كما قلت لا في رفع الخاص بالعام كما قلتم، فإن من أثبت التعارض بين الخاص والعام ترك العمل بالخاص أصلا وببعض ما تناوله العام، ومن قال بترتيب العام على الخاص هو عامل بحقيقة الخاص وبالعام أيضا فيما تناوله بحسب الامكان فيكون هذا أولى بالمصير إليه.
قلنا: هذا إنما يستقيم بعد ثبوت الامكان وبعد ما قررنا أن كل واحد منهما موجب فيما تناوله الحكم قطعا لا إمكان، أرأيت لو قال قائل: أنا أعمل بالعام في كل ما تناوله وأحمل الخاص على المجاز فأعمل به وبهذا الطريق يكون هذا عملا منه بالدليلين لا، فكذلك قولك: أنا أعمل بالخاص وأترك موجب العام فيما تناوله (لا يكون) عملا بهما مع أن موجب الدليل ليس كله العمل به بل العمل به والمدافعة به عند
التعارض بمنزلة الشهادات في الخصومات بين العباد فإثبات المدافعة عند المعارضة بين الخاص والعام على ما اقتضاه موجب كل واحد منهما لا يكون تركا للعمل
بأحدهما، ثم سوى الشافعي رحمه الله فيما أثبته من حكم العموم بين ما يحتمل العموم وبين ما لا يحتمله لعدم محله فيما هو المحتمل فجعل كل واحد منهما حجة لاثبات الحكم مع ضرب شبهة.
وبيان هذا في قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) وقال تعالى: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) وقال تعالى: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون !) فإن نفي المساواة بينهما على العموم غير محتمل لعلمنا بالمساواة بينهما في حكم الوجود والانسانية والبشرية والصورة، فقال مع هذا العلم يكون هذا العام حجة فيما هو الممكن حتى لا يسوى بين الكافر والمؤمن في حكم القصاص وفي حكم شراء العبد المسلم ولا يشاكله، لان العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الامكان وانعدام الامكان فيما لا يحتمله بمنزلة دليل الخصوص شرعا، فكما أن دليل الخصوص فيما يحتمل العموم لا يخرج العام بصيغة العام من الحكم فيما يثبت من أن يكون حجة فيما وراء ذلك فكذلك عدم احتمال العموم حسا لا يخرج العام من أن يكون حجة فيما يحتمله.
وحاصل مذهبه أنه يسوي بين محتمل الحال وبين محتمل اللفظ فيما يثبت بصيغة العام من الحكم وفيما يثبت من الشبهة المانعة من العلم به قطعا، ونحن نقول: فيما ذهب إليه تحقق الحرج الذي هو مدفوع وهو الوقوف على مراد المتكلم ليعمل به فيما يحتمل العموم، واعتبار الارادة المغيرة للعموم عن حقيقتها فيما يحتمل العموم حتى لا يكون موجبا قطعا فيما تناوله، وقد بينا أن ذلك لا يجوز شرعا، وبه تبين فساد التسوية بين محتمل الحال وبين محتمل اللفظ، وتبين أن موجب العموم لا يثبت فيما لا يمكن العمل بعمومه لانعدام محل العموم، وسنقرر هذا في الفصل الذي يأتي وهو العام إذا خصص منه شئ، وإنما سوينا في موجب العام بين الخبر والامر والنهي لان ذلك حكم صيغة العموم، وهذه الصيغة متحققة في الاخبار كما في الامر والنهي، والله أعلم بالصواب.
فصل: في بيان حكم العام إذا خصص منه شئ قال رضي الله عنه (وعن والديه): كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول من عند نفسه لا على سبيل الحكاية عن السلف: العام إذا لحقه خصوص لا يبقى حجة بل يجب التوقف فيه إلى البيان سواء كان دليل الخصوص معلوما أو مجهولا إلا أنه يجب به أخص الخصوص إذا كان معلوما.
وقال بعضهم: إذا خص منه شئ مجهول فكذلك الجواب وإن خص منه شئ معلوم فإنه يبقى موجبا الحكم فيما وراء المخصوص قطعا.
وقال بعضهم: هكذا فيما إذا خص شئ معلوم، وإن خص منه شئ مجهول يسقط دليل الخصوص ويبقى العام موجبا حكمه كما كان قبل دليل الخصوص.
قال رضي الله عنه: والصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا رحمهم الله في العام إذا لحقه خصوص يبقى حجة فيما وراء المخصوص سواء كان المخصوص مجهولا أو معلوما إلا أن فيه شبهة حتى لا يكون موجبا قطعا ويقينا، بمنزلة ما قال الشافعي رحمه الله في موجب العام قبل الخصوص، والدليل على أن المذهب هذا أن أبا حنيفة رضي الله عنه استدل على فساد البيع بالشرط بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط وهذا عام دخله خصوص، واحتج على استحقاق الشفعة بالجوار إذا كان عن ملاصقة بقول النبي عليه السلام: الجار أحق بصقبه وهذا عام قد دخله خصوص، واستدل محمد على فساد بيع العقار قبل القبض بنهيه عليه السلام عن بيع ما لم يقبض وهو عام لحقه خصوص، وأبو حنيفة رحمه الله خص هذا العام بالقياس، فعرفنا أنه حجة للعمل من غير أن يكون موجبا قطعا، لان القياس لا يكون موجبا قطعا فكيف يصلح أن يكون معارضا لما يكون موجبا قطعا ! وتبين أن هذا العام دون الخبر الواحد، لان القياس لا يصلح معارضا للخبر الواحد عندنا، ولهذا أخذنا بالخبر
الواحد الموجب للوضوء عند القهقهة في الصلاة وتركنا القياس به، وأبو حنيفة أخذ
بخبر الواحد في الوضوء بنبيذ التمر وترك القياس به، ثم إن خبر الواحد لا يوجب العلم قطعا فما هو دونه أولى.
وأما الكرخي احتج وقال: الخصوص الذي يلحق العام يسلب حقيقته فيصير مجازا ومجازه في مراد المتكلم، وذلك لا يتبين إلا ببيان من جهته فصار مجملا يجب التوقف فيه إلى البيان بمنزلة صيغة العموم فيما لا يحتمل العموم، نحو قوله تعالى: (وما يستوي الاعمى والبصير) فإنه لما انتفى حقيقة العموم فيه لم يكن حجة بدون البيان فكذلك هذا، وهذا لانه لو بقي حجة فيما وراء المخصوص كان حقيقة ولا وجه للجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد إلا أن يكون أخص الخصوص منه معلوما فيكون ثابتا به لكونه متيقنا كالذي يقوم فيه دليل البيان فيما لا يمكن العمل فيه بحقيقة العموم، ولان دليل الخصوص بمنزلة الاستثناء فإنه يتبين به أن المخصوص لم يكن داخلا فيما هو المراد بالكلام، كما يتبين بالاستثناء أن الكلام عبارة عما وراءه ولهذا لا يكون دليل الخصوص إلا مقارنا، فأما ما يكون طارئا فهو دليل النسخ لا دليل الخصوص، وإن كان المستثنى مجهولا يصير ما وراءه بجهالته مجهولا كما أن المستثنى إذا تمكن فيه شك يصير ما وراءه مشكوكا فيه، حتى إذا قال: مماليكي أحرار إلا سالما وبزيغا لم يعتق واحد منهما وإن كان المستثنى أحدهما لانه مشكوك فيه، فيثبت حكم الشك فيهما، وإذا صار ما بقي مجهولا لم يصلح حجة بنفسه بل يجب الوقف فيه، كما في قوله تعالى: (وما يستوي الاعمى والبصير) وكذلك إن كان دليل الخصوص معلوما، لانه يجوز أن يكون معلولا وهو الظاهر، فإن دليل الخصوص نص على حدة فيكون قابلا للتعليل ما لم يمنع مانع من ذلك وبالتعليل لا ندري أن حكم الخصوص إلى أي مقدار يتعدى فيبقى ما وراءه مجهولا أيضا، وعلى ما قاله الكرخي
يسقط الاحتجاج بأكثر العمومات لان أكثر العمومات قد خص منها شئ، وهذا خلاف ما حكينا من مذهب السلف في الصدر الاول فإنهم احتجوا بالعمومات التي يلحقها (خصوص كما احتجوا بالعمومات التي لم يلحقها خصوص، ودعواه أنه
يصير به مجازا كلام لا) معنى له، فإن الحقيقة ما يكون مستعملا في موضوعه، والمجاز ما يكون معدولا به عن موضوعه، وإذا كان صيغة العموم يتناول الثلاثة حقيقة كما يتناول المائة والالف وأكثر من ذلك فإذا خص البعض من هذه الصيغة كيف يكون مجازا فيما وراءه وهو حقيقة فيه ؟ ! فإن قيل: البعض غير الكل من هذه الصيغة وإذا كان حقيقة هذه الصيغة للكل فإذا أريد به البعض كان مجازا فيه، ثم هذا إنما يستقيم على ما يقوله بعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز التخصيص من العموم إلى أن يبقى منه ما دون الثلاث، فأما على أصلكم فيجوز التخصيص إلى أن لا يبقى منه أكثر من واحد ولا شك أن صيغة الجمع لا تتناول الواحد حقيقة ؟ قلنا: نعم ولكن ما وراء المخصوص يتناوله موجب الكلام على أنه كل لا بعض بمنزلة الاستثناء، فإن الكلام يصير عبارة عما وراء المستثنى بطريق أنه كل لا بعض، ولهذا إذا لم يبق شئ بعد دليل الخصوص كان نسخا لا تخصيصا كما في الاستثناء، فإنه إذا لم يبق شئ بعد الاستثناء بحال لا يكون ذلك استثناء صحيحا، وإذا كان الباقي منه دون الثلاث فهو كل أيضا، وإن كانا بصيغة العموم، لانه لا يحتمل أن يكون الباقي أكثر من ذلك على وجه يكون الباقي جمعا حقيقة، فبهذا الطريق صححنا التخصيص كما يصح استثناء الكل بهذا الطريق، فإنه لو قال: مماليكي أحرار إلا فلانا وفلانا، وليس له سواهما كان الاستثناء صحيحا لاحتمال أن يكون المستثنى بعضا إذا كان له سواهما، بخلاف ما لو قال: مماليكي أحرار إلا مماليكي، وأما وجه القول الثاني ما بينا أن دليل
الخصوص بمنزلة الاستثناء، فإذا كان المخصوص مجهولا كان ما وراءه مجهولا أيضا والمجهول لا يكون دليلا موجبا، وأما إذا كان معلوما فما وراءه يكون معلوما أيضا، وكما أن الكلام المقيد بالاستثناء يصير عبارة عما وراء المستثنى ويكون مقطوعا به إذا
كان المستثنى معلوما فكذلك العام إذا لحقه خصوص معلوم يصير عبارة عما وراءه ويكون موجبا فيه ما هو حكم العام، لان دليل الخصوص لا يتعرض لما وراءه فيبقى العام فيما وراءه حجة موجبة قطعا، ولا معنى لما قال الكرخي رحمه الله إنه يحتمل التعليل لانه إذا كان بمنزلة الاستثناء لا يحتمل التعليل فإن المستثنى معدوم على معنى أنه لم يكن مرادا بالكلام أصلا والعدم لا يعلل، وعلى هذا القول يسقط الاحتجاج بآية السرقة، لانه لحقها خصوص مجهول وهو ثمن المجن على ما روي كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دون ثمن المجن وكذلك بآية البيع فإنه لحقها خصوص مجهول وهو حرمة الربا، وكذلك بالعمومات الموجبة للعقوبة وقد لحقها خصوص مجهول وهو السقوط باعتبار تمكن الشبهة على ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ادرؤوا الحدود بالشبهات.
ووجه القول الثالث أن التخصيص إنما يكون بكلام مبتدأ بصيغة على حدة تتناول بعض ما تناوله العام على خلاف موجبه مما لو كان طارئا كان رافعا على وجه النسخ فإذا كان مقارنا كان ثابتا، ومثل هذا لا يصلح مغيرا صفة الكلام الاول، فكيف يصلح مغيرا له وهو غير متصل بتلك الصيغة ؟ فبقي الكلام الاول صادرا من أهله في محله فيكون موجبا حكمه، وحكم العام أنه كان موجبا قطعا، فإذا كان المخصوص معلوما بقي العام فيما وراءه موجبا قطعا، ولا يكون موجبا في موضع الخصوص لتحقق المعارضة بين دليل الخصوص والعموم فيه فإذا كان مجهولا في نفسه فالمجهول لا يصلح معارضا للمعلوم، وقد بينا أن العام موجب للحكم فيما تناوله قطعا
بمنزلة الخاص فيما تناوله، فإذا لم تستقم المعارضة بكون المعارض مجهولا سقط دليل الخصوص وبقي حكم العام على ما كان في جميع ما تناوله، وهذا بخلاف الاستثناء فإنه داخل على صيغة الكلام، ألا ترى أنه لا يستقيم بدون أصل الكلام، فإن قول القائل إلا زيدا لا يكون مفيدا شيئا فإذا دخل على صيغة الكلام كان مغيرا لها فيكون أصل الكلام عبارة عما وراء المستثنى وذلك مجهول عند جهالة المستثنى والجهالة
في المستثنى لا تمنع صحة الاستثناء، لانه يبين أن صيغة الكلام لم تتناول المستثنى أصلا وما لم يتناوله الكلام فلا أثر للجهالة فيه، وهذا بخلاف صيغة العام فيما لا يحتمله العموم، لان الكلام إنما يكون مفيدا حكمه إذا صدر من أهله في محله، فإن البيع كما لا يصح من المجنون لانعدام الاهلية لا يصح في الحر لانعدام المحلية، فكذلك صيغة العموم في محل لا يقبل العموم بمنزلة الصادر من غير أهله فلا يكون موجبا حكم العموم، وإذا لم ينعقد موجبا حكم العام وليس وراءه شئ معلوم يمكن أن يجعل الكلام عبارة عنه بقي مجملا فيما هو المراد، فأما إذا صدر من أهله في محله كان موجبا حكمه إلا أن يمنع منه مانع والمجهول لا يصلح أن يكون مانعا فبقي أصل الكلام معتبرا في موجبه، ألا ترى أن البائع بعد تمام البيع إذا أجل المشتري في الثمن أجلا مجهولا من غير أن يشترط ذلك في أصل البيع يبقى البيع موجبا حالا للثمن، لانه انعقد موجبا لذلك، وهذا المانع - وهو الاجل - لا يصلح أن يكون مؤخرا للمطالبة فيبقى الحكم الاول على حاله.
وأما وجه القول الرابع - وهو الصحيح - أن دليل الخصوص بمنزلة الاستثناء في حق الحكم وبمنزلة الناسخ باعتبار الصيغة، لان بدليل الخصوص يتبين بأن المراد إثبات الحكم فيما وراء المخصوص لا أن يكون المراد رفع الحكم عن الموضع المخصوص بعد أن كان ثابتا، ولهذا لا يكون إلا مقارنا حتى لو كان طارئا يجعل
نسخا لا خصوصا لانه لا يمكن أن يجعل مبينا أن المراد ما وراءه، ومن حيث الصيغة هو كلام مبتدأ مفهوم بنفسه مفيد للحكم وإن لم تتقدمه صيغة العام، فعرفنا أنه من حيث الصيغة معتبر بدليل النسخ لانه منفصل عن العام، ومن حيث الحكم هو بمنزلة الاستثناء لانه متصل به حكما حتى لا يجوز إلا مقارنا له فلم يجز إلحاقه بأحدهما خاصة بل يعتبر في كل حكم بنظيره كما هو الاصل فيما تردد بين شيئين وأخذ حظا معتبرا من كل واحد منهما فإنه يعتبر بهما، فنقول: إذا كان المستثنى مجهولا فاعتبار جانب الصيغة فيه يسقط دليل الخصوص ويبقى حكم العام في جميع ما تناوله، واعتبار جانب الحكم فيه وهو أنه بمنزلة الاستثناء يمنع ثبوت الحكم فيما وراء المخصوص لكونه
مجهولا فلا نبطل واحدا منهما بالشك، ومعنى هذا أنا لا نسقط دليل الخصوص لكونه مجهولا بالشك، ولا نخرج ما وراءه من أن يكون صيغة العام حجة فيه بالشك، وكذلك إذا كان المخصوص معلوما فإنه من حيث الصيغة هو نص على حدة قابل للتعليل وبالتعليل ما ندري ما يتعدى إليه حكم الخصوص مما تناوله صيغة العام، وباعتبار الحكم لا يقبل التعليل لانه موجب للحكم على أنه تبين به أن المراد ما وراءه كالاستثناء وهذا لا يقبل التعليل، فاعتبار الصيغة يخرج العام من أن يكون حجة فيما وراء المخصوص، وباعتبار الحكم يوجب أن يكون العام موجبا للحكم قطعا فيما وراء المخصوص، فلا يبطل معنى الحجة بالشك ولكن يتمكن فيه ضرب شبهة، فإن ما يكون ثابتا من وجه دون وجه لا يكون مقطوعا به، والحكم إنما نثبت بحسب الدليل ولهذا كان حجة موجبة العمل بها، ولا يكون موجبه العلم قطعا، وهذا بخلاف دليل النسخ فإن عمله في رفع الحكم باعتبار المعارضة وذلك لا يكون إلا فيما تناوله النص بعينه، فإن التعليل فيه يؤدي إلى إثبات المعارضة بين النص والعلة المستنبطة بالرأي والرأي لا يكون معارضا للنص، ولهذا
لا نشتغل بالتعليل في إثبات النسخ، فأما دليل الخصوص، وإن كان نصا على حدة، فإنما يوجب الحكم على الوجه الذي يوجبه الاستثناء، لانه في معنى الحكم بمنزلة الاستثناء كما قررنا، فلا يخرج من أن يكون محتملا للتعليل، وبطريق التعليل تتمكن الشبهة فيما يبقى وراء المخصوص مما يكون العام موجبا للحكم فيه، ولهذا جوزنا تخصيص هذا العام بالقياس، لان ثبوت الحكم به فيما وراء المخصوص مع شك في أصله واحتمال، فيجوز أن يكون القياس معارضا له بخلاف خبر الواحد فإنه لا شك في أصله، وإنما الاحتمال في طريقه باعتبار توهم غلط الراوي أو ميله عن الصدق إلى الكذب، فمن حيث إنه لا شك فيه متى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقوى من القياس فلا يصلح أن يكون القياس معارضا له.
وبيان هذه الاصول من الفروع أن من جمع بين حر وعبد فباعهما بثمن واحد أو بين ميتة وذكية أو بين خل وخمر لم يجز البيع أصلا، لان الحر والميتة والخمر لا يتناولها العقد
أصلا فيكون بائعا لما هو مال متقوم منهما بحصته من الالف إذا قسم عليهما والبيع بالحصة لا ينعقد صحيحا ابتداء، كما لو قال: بعت منك هذا العبد بما يخصه من الالف إذا قسم على قيمته وعلى قيمة هذا العبد الآخر، فبهذا الفصل يتبين ما يكون بمنزلة الاستثناء أنه يجعل الكلام عبارة عما وراء المستثنى حكما، ولو باع منه عبدين فهلك أحدهما قبل القبض أو استحق أحدهما أو كان أحدهما مدبرا أو مكاتبا يبقى العقد صحيحا في الآخر، لان العقد يتناولهما باعتبار صفة المالية والتقوم فيهما وهو المعتبر في المحل لتناول العقد إياه، ثم خرج أحدهما لصيانة حق مستحق إما للعبد في نفسه أو للغير أو لتعذر التسليم بهلاكه فيبقى العقد في الآخر صحيحا بحصته، وهذا نظير دليل النسخ فإنه يرفع الحكم الثابت في مقدار ما تناوله النص الذي هو ناسخ ويبقى ما وراء ذلك من حكم العام على ما كان قبل ورود الناسخ.
ونظير دليل الخصوص
البيع بشرط الخيار فإنه ينعقد صحيحا بمنزلة ما لو لم يكن فيه خيار، وفي حق الحكم كان غير منعقد على معنى أن الحكم متعلق بسقوط الخيار على ما يأتيك بيانه في موضعه أن شرط الخيار لا يدخل في أصل السبب وإنما يدخل على الحكم، فيجب اعتباره في كل جانب بنظيره حتى إن باعتبار السبب إذا سقط الخيار استحق المشتري بزوائده المتصلة أو المنفصلة، وباعتبار الحكم إذا أعتق المشتري والخيار مشروط البائع ثم سقط الخيار لم ينفذ العتق، وعلى هذا قال في الزيادات: لو باع من رجل عبدين وشرط الخيار في أحدهما دون الآخر للبائع أو المشتري، فإن لم يكن ثمن كل واحد منهما مسمى لم يجز العقد في واحد منهما، وإن كان ثمن كل واحد منهما مسمى جاز في واحد منهما، فإن لم يعين المشروط فيه الخيار منهما لم يجز العقد أيضا، وإن عينا ذلك جاز العقد في الآخر ولزم بالثمن المسمى له، لان اشتراط الخيار باعتبار الحكم يعدم العقد في المشروط فيه الخيار، فإذا كان مجهولا كان العقد في الآخر ابتداء في المجهول، وإن كان معلوما ولم يكن ثمن كل واحد منهما مسمى كان العقد في الآخر ابتداء بالحصة فلا ينعقد صحيحا، وباعتبار السبب كان متناولا لهما بصفة الصحة، فإذا كان الذي لا خيار فيه منهما معلوما وكان ثمنه مسمى لزم العقد فيه ولم يجعل العقد في الآخر بمنزلة شرط فاسد في الذي لا خيار فيه، بخلاف ما قاله أبو حنيفة رحمه الله فيما إذا باع حرا وعبدا وسمى ثمن كل واحد منهما لم ينعقد البيع في العبد صحيحا،
لان اشتراط قبول العقد في الحر شرط فاسد، فقد جعله مشروطا في قبوله العقد في القن حين جمع بينهما في الايجاب، والبيع يبطل بالشروط الفاسدة، وأما اشتراط قبول العقد في الذي فيه الخيار لا يكون شرطا فاسدا، لان البيع بشرط الخيار منعقد شرطا صحيحا من حيث السبب، فكان العقد في الآخر لازما، والله أعلم.
فصل: في بيان ألفاظ العموم ألفاظ العموم قسمان: عام بصيغته ومعناه، وقسم فرد بصيغته عام بمعناه.
فأما ما هو عام بصيغته ومعناه فكل لفظ هو للجمع نحو الرجال والنساء والمسلمين والمشركين والمنافقين فإنها عام صيغة، لان واضع اللغة وضع هذه الصيغة للجماعة قال رجل ورجلان ورجال وامرأة وامرأتان ونساء، وهو عام بمعناه، لانه شامل لكل ما تناوله عند الاطلاق، فأدنى ما يطلق عليه هذا اللفظ الثلاثة، لان أدنى الجمع الصحيح ثلاثة، نص عليه محمد رحمه الله في السير الكبير في الانفال وغيرها، ومن قال لفلان على دراهم يلزمه الثلاثة، والمرأة إذا اختلعت من زوجها بما في يدها من دراهم فإذا ليس في يدها شئ يلزمها ثلاثة دراهم، لان أدنى الجمع متيقن به عند ذكر الصيغة وفيما زاد عليه شك واحتمال فلا يجب إلا المتيقن، فظن بعض أصحابنا رحمهم الله أن على قول أبي يوسف أدنى الجمع اثنان على قياس مسألة الجمعة وليس كذلك، فإن عنده الجمع الصحيح ثلاثة إلا أنه يجعل الامام من جملة الجمع الذي تتأدى بهم الجمعة على قياس سائر الصلوات فإن الامام من جملة الجماعة، ولهذا يقدم الامام إذا كان خلفه رجلان فصاعدا.
وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: الشرط في الجمعة الجماعة والامام جميعا فلا يكون الامام محسوبا من عدد الجماعة فيشترط ثلاثة سواه، وفي سائر الصلوات الامام ليس بشرط لادائها فيمكن أن يجعل الامام من جملة الجماعة، فإذا كان مع الامام رجلان اصطفا خلفه.
وبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله يقولون: الجماعة هي المثنى فصاعدا، واستدلوا بقوله عليه السلام: الاثنان فما فوقهما جماعة ولان اسم الجماعة
حقيقة فيما فيه معنى الاجتماع وذلك موجود في الاثنين، ألا ترى أن في الوصايا والمواريث جعل للمثنى حكم الجماعة حتى لو أوصى لاقرباء فلان يتناول المثنى فصاعدا، وللاثنين من الميراث ما للثلاث فصاعدا، والاخوان يحجبان الام من الثلث إلى السدس بقوله
تعالى: (فإن كان له إخوة) وفي كتاب الله تعالى إطلاق عبارة الجمع على المثنى لقوله تعالى (هذان خصمان اختصموا) وقال تعالى: (وداود وسليمان) إلى قوله: (وكنا لحكمهم شاهدين) وقال تعالى: (إذ تسوروا المحراب) إلى قوله تعالى: (خصمان بغى بعضنا على بعض) وكذلك في استعمال الناس فإن الاثنين يقولان نحن فعلنا كذا بمنزلة الثلاثة.
وحجتنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب ثم يستقيم نفي صيغة الجماعة عن المثنى بأن يقول: ما في الدار رجال إنما فيها رجلان، وقد بينا أن اللفظ إذا كان حقيقة في الشئ لا يستقيم نفيه عنه، وإجماع أهل اللغة يشهد بذلك فإنهم يقولون الكلام ثلاثة أقسام وحدان وتثنية وجمع، ثم للوحدان أبنية مختلفة وكذلك للجمع، وليس ذلك للتثنية إنما لها علامة مخصوصة، فعرفنا أن المثنى غير الجماعة، ولما وضعوا للمثنى لفظا على حدة فلو قلنا بأن للمثنى حكم الجماعة لكان اللفظ الموضوع للثلاثة على خلاف الموضوع للمثنى تكرارا محضا وكل لفظ موضوع لفائدة جديدة، ألا ترى أن بعد الثلاث لم يوضع لما زاد عليها لفظ على حدة لما كانت صيغة الجماعة تجمعها، وكذلك اللفظ المفرد والتثنية يذكر من غير عدد، يقال: رجل ورجلان (ثم يذكر مقرونا بالعدد بعد ذلك، فيقال: ثلاثة رجال وأربعة رجال) ولا يقال واحد رجل ولا اثنان رجلان، وتسمية الثلاثة جماعة بمعنى الاجتماع كما قالوا ولكن اجتماع بصفة وهو اجتماع لا يتحقق فيه معنى يعارض الافراد على التساوي كما في الثلاثة، فإن الفرد من أحد الجانبين يقابله المثنى من جانب آخر، فأما في الاثنين يتعارض الافراد على
التساوي من حيث إن كل واحد من الجانبين فرد، فعند الانضمام يكون اسم المثنى حقيقة فيهما لا اسم الجماعة، وتأويل الحديث أن في حكم الاصطفاف خلف الامام الاثنان فما فوقهما جماعة فقد بينا المعنى فيه، فأما في المواريث فاستحقاق الاثنين
الثلثين ليس بالنص الوارد بعبارة الجماعة وهو قوله تعالى: (فلهن ثلثا ما ترك) إنما ذلك للثلاث فصاعدا، وإنما استحقاق الاثنين الثلثين بإشارة النص في قوله: (للذكر مثل حظ الانثيين) فإن نصيب الابن مع الابنة الثلثان، فيثبت به أن ذلك حظ الانثيين وما بعده لبيان أنهن وإن كن أكثر من اثنتين لا يكون لهن إلا الثلثان عند الانفراد، والحجب بالاخوين عرفناه باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، على ما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعثمان رضي الله عنه: الاخوة في لسان قومك لا يتناول الاثنين، فقال: نعم ولكن لاستحي أن أخالفهم فيما رأوا.
ألا ترى أن الحجب ثبت بالاخوات المفردات بهذا الطريق، فإن اسم الاخوة لا يتناول الاخوات المفردات، على أن الاسم قد يتناول المثنى مجازا لاعتبار معنى الاجتماع مطلقا، فبهذا الطريق أثبتنا حكم الحجب والتوريث للمثنى، والوصية أخت الميراث فيكون ملحقا به.
وقول المثنى: نحن فعلنا كذا إخبار عن كل واحد منهما عن نفسه وعن غيره، على أن جعله تبعا لنفسه مجازا ومثل هذا قد يكون من الواحد أيضا، يقول: قد فعلنا كذا وأمرنا بكذا، وهذا لا يدل على أن اسم الجماعة يتناول الفرد حقيقة.
وفيما تلونا من الآيات بيان أن المتخاصمين كانا اثنين ويحتمل أن يكون الحضور معهما جماعة وصيغة الجماعة تنصرف إليهم جميعا، وعلى هذا قوله تعالى: (فقد صغت قلوبكما) فإن أكثر الاعضاء المنتفع بها في البدن زوج فما يكون فردا لعظم المنفعة فيه يجعل بمنزلة ما هو زوج فتستقيم العبارة عن تثنيته بالجمع ويبين أن أدنى الجمع الصحيح ثلاثة صورة أو معنى، وعلى هذا لو قال إن اشتريت عبيدا فعلي كذا أو إن تزوجت نساء فإنه لا يحنث إلا بالثلاثة فصاعدا إلا أنه إذا دخل الالف واللام في هذه الصيغة نجعلها للجنس مجازا، لان اللام لتعريف المعهود
في الاصل، فإن الرجل يقول رأيت رجلا ثم كلمت الرجل: أي ذلك الرجل بعينه،
وقال تعالى: (كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) : أي ذلك الرسول بعينه، فعرفنا أنه المعهود ولكن ليس فيما تناوله صيغة الجماعة معهود ليكون تعريفا لذلك، فلو لم نجعله للجنس لم تبق للالف واللام فائدة، فإذا جعل للجنس كان فيه اعتبار المعنيين جميعا: معنى المعهود من حيث إنه يتناول هذا الجنس من أقسام الاجناس فيكون تعريفا له، ومعنى العموم من حيث إن في كل جنس يوجد معنى الجماعة فلاعتبار المعنيين جميعا جعلناه للجنس، ثم تناول الواحد فصاعدا حتى إذا قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد أو كلمت الناس يحنث بالواحد، لان الواحد في الجنس بمنزلة الثلاثة في الجماعة على معنى أن اسم الجنس يتناول الواحد حقيقة، فإن آدم صلوات الله عليه هو الاصل في جنس الرجال، وحواء رضي الله عنها هي الاصل في جنس النساء، وحين لم يكن غيرهما كان اسم الجنس حقيقة لكل واحد منهما، فبكثرة الجنس لا تتغير تلك الحقيقة، فالادنى المتيقن به في حقيقة اسم الجنس الواحد كالثلاثة في الجماعة، فعند الاطلاق ينصرف إليه إلا أن يكون المراد الجمع فحينئذ لا يحنث قط ويدين في القضاء لانه نوى حقيقة كلامه، بخلاف ما إذا نوى التخصيص في صيغة العام فإنه لا يدين في القضاء.
فأما ما يكون فردا بصيغته عاما بمعناه فهو بمنزلة اسم الجن والانس فإنه فرد بصيغته، ألا ترى أنه ليس له وحدان عام بمعناه وإن لم يذكر فيه الالف واللام بمنزلة الرجال والنساء، وكذلك الرهط والقوم فإنه فرد بصيغته إذ لا فرق بين قول القائل رهط وقوم وبين قوله زيد وعمرو، وهو (عام) بمعناه، والجماعة والطائفة كذلك إلا أن الطائفة في لسان الشرع يتناول الواحد فصاعدا، قال ابن عباس في قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) إنه الواحد فصاعدا، وقال قتادة في قوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) إنه الواحد فصاعدا، وهذا لاعتبار صيغة الفرد، وجعلوه بمنزلة الجنس بغير حرف اللام كما يكون مع حرف
اللام الذي هو للعهد، وعلى هذا قلنا لو حلف لا يشرب ماء يحنث بشرب القليل، كما
لو قال الماء لان صيغته صيغة الفرد والمراد به الجنس فيتناول القليل والكثير، سواء قرن به اللام أو لم يقرن، لانه لما خلا عن معنى الجماعة صيغة إذ ليس له وحدان كان جنسا، فإدخال الالف واللام فيه يكون للتأكيد، كالرجل يقول: رأيت قوما وافدين ورأيت القوم الوافدين على فلان كان ذلك كتأكيد معنى الجنس.
ثم اسم الجنس يتناول الادنى حقيقة من الوجه الذي قررنا أنه لو تصور أن لا يبقى من الماء إلا ذلك القليل كان اسم الماء له حقيقة ولا يتغير ذلك بكثرة الجنس.
وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله: إن الحالف إنما يمنع نفسه بيمينه عما في وسعه وفي وسعه شرب القليل من الجنس وليس في وسعه شرب الجميع فلعلمنا بأنه لم يرد جميع الجنس صرفناه إلى أقل ما يتناوله اسم الجنس على احتمال أن يكون مراده الكل حتى إذا نواه لم يحنث قط.
ومن هذا القسم كلمة من فإنها كلمة مبهمة وهي عبارة عن ذات من يعقل، وهي تحتمل الخصوص والعموم، ألا ترى أنه إذا قيل من في الدار يستقيم في جوابه فيها فلان وفلان وفلان ؟ وإذا قال من أنت يستقيم في جوابه أنا فلان فمتى وصلت هذه الكلمة بمعهود كانت للخصوص وإذا وصلت بغير المعهود تحتمل العموم والخصوص والاصل فيها العموم، قال الله تعالى: (ومنهم من يستمع إليك) وقال: (ومنهم من ينظر إليك) إلى قوله تعالى: (ولو كانوا لا يبصرون) وقال تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) والمراد العموم، وقال صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا فله سلبه ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وعلى هذا الاصل قلنا إذا قال من شاء من عبيدي العتق فهو حر فشاؤوا جميعا عتقوا لان كلمة من تقتضي العموم وإنما أضاف المشيئة إلى من دخل تحت كلمة من فيتعمم بعمومه.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال من شئت من عبيدي عتقه فهو حر فشاء عتقهم
جميعا عتقوا أيضا، لان كلمة من تعم العبيد ومن لتمييز هذا الجنس من سائر الاجناس بمنزلة قوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الاوثان) وإضافة المشيئة إلى خاص لا يغير العموم الثابت بكلمة من، كما في قوله تعالى: (فأذن لمن شئت منهم) وقال تعالى: (ترجي من تشاء منهن) ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال: له أن يعتقهم جميعا إلا واحدا منهم، لان كلمة من للتعميم ومن للتبعيض وهو الحقيقة فإذا أضاف المشيئة
إلى العام الداخل تحت كلمة من يرجح جانب العموم فيه، فإذا أضافها إلى خاص يبقى معنى الخصوص معتبرا فيه مع العموم فيتناول بعضا عاما وذلك في أن يتناولهم إلا واحدا منهم.
وإنما رجحنا معنى العموم فيما تلونا من الآيتين بالقرينة المذكورة فيها وهو قوله تعالى: (واستغفر لهم الله) وقال تعالى: (ذلك أدنى أن تقر أعينهن) وعلى احتمال الخصوص في هذه الكلمة قال في السير الكبير: إذا قال من دخل منكم هذا الحصن أولا فله من النفل كذا فدخل رجلان معا لم يستحق واحد منهما شيئا، لان الاول اسم لفرد سابق فإذا وصله بكلمة من وهو تصريح بالخصوص يرجح معنى الخصوص فيه فلا يستحق النفل إلا واحد دخل سابقا على الجماعة.
ونظيرها كلمة ما فإنها تستعمل في ذات ما لا يعقل وفي صفات ما يعقل، حتى إذا قيل ما زيد يستقيم في جوابه عالم أو عاقل، وإذا قيل ما في الدار يستقيم في جوابه فرس وكلب وحمار ولا يستقيم في الجواب رجل وامرأة، فعرفنا أنه يستعمل في ذات ما لا يعقل بمنزلة كلمة من في ذات من يعقل، ألا ترى أن فرعون عليه اللعنة حين قال لموسى عليه السلام: وما رب العالمين ؟ وقال موسى: رب السموات والارض ؟ أظهر التعجب من جوابه حتى نسبه إلى الجنون، يعني أنا أسأله عن الماهية وهو السؤال عن ذات الشئ أجوهر هو أم عرض، وهو يجيبني عن المنية ألا إن الله تعالى
يتعالى عما سأل اللعين، ومن شأن الحكيم إذا سمع لغوا أن يعرض عنه ويشتغل بما هو مفيد، قال تعالى: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) وهذا ليس جوابا عن اللغو ولكن إعراض عنه وإتمام لذلك الاعراض بالاشتغال بما هو مفيد، وكذلك فعل موسى عليه السلام، فإنه أظهر الاعراض عن اللغو بالاشتغال بما هو مفيد وهو أن الصانع جل وعلا إنما يعرف بالتأمل في مصنوعاته وبمعرفة أسمائه وصفاته، وفي هذا بيان أن اللعين أخطأ في طلب طريق المعرفة بالسؤال عن الماهية.
وقد تأتي كلمة ما بمعنى من، قال تعالى: (وما بناها) معناه
ومن بناها إلا أن الحقيقة في كل كلمة ما بينا، وعلى هذا الاصل كان الاختلاف في قوله لامرأته: اختاري من الثلاث ما شئت فاختارت الثلاث، فإن عندهما تطلق ثلاثا، وعند أبي حنيفة رحمه الله ثنتين بمنزلة قوله: أعتق من عبيدي من شئت، ولاحتمال معنى العموم في كلمة ما قلنا إذا قال لامته إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية إنها لا تعتق، لان الشرط أن يكون جميع ما في بطنها غلاما.
ونظير هاتين الكلمتين كلمة الذي فإنها مبهمة مستعملة فيما يعقل وفيما لا يعقل وفيها معنى العموم على نحو ما في الكلمتين، حتى إذا قال: إن كان الذي في بطنك غلاما كان بمنزلة قوله إن كان في بطنك غلاما.
وكلمة أين وحيث للتعميم في الامكنة، قال الله تعالى: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وقال تعالى: (أينما تكونوا يدرككم الموت) ولهذا لو قال لامرأته: أنت طالق أين شئت وحيث شئت يقتصر على المجلس، لانه ليس في لفظه ما يوجب تعميم الاوقات.
وأما متى كلمة مبهمة لتعميم الاوقات، ولهذا لو قال: أنت طالق متى شئت لم يتوقف ذلك على المجلس.
وأما كلمة كل فإنها توجب الاحاطة على وجه الافراد، قال الله تعالى: (إنا كل شئ خلقناه بقدر) ومعنى الافراد أن كل واحد من المسميات التي توصل بها كلمة كل يصير مذكورا على سبيل الانفراد كأنه ليس معه غيره، لان هذه الكلمة صلة في الاستعمال حتى لا تستعمل وحدها لخلوها عن الفائدة، وهي تحتمل الخصوص نحو كلمة من إلا أن معنى العموم فيها يخالف معنى العموم في كلمة من، ولهذا استقام وصلها بكلمة من، قال الله تعالى: (كل من عليها فان) حتى لو وصلت باسم نكرة تقتضي العموم في ذلك الاسم، فأما إذا قال لعبده: أعط كل رجل من هؤلاء درهما كانت موجبة للعموم فيهم، ولهذا لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق تطلق كل امرأة يتزوجها على العموم، ولو تزوج امرأة
مرتين لم تطلق في المرة الثانية لانها توجب العموم فيما وصلت به من الاسم دون الفعل إلا أن توصل بما فحينئذ ما يتعقبها الفعل دون الاسم، لانه يقال كلما ضرب ولا يقال كلما رجل فيقتضي التعميم فيما يوصل به، قال الله تعالى: (كلما نضجت جلودهم) فإذا قال: كلما تزوجت امرأة فتزوج امرأة مرارا تطلق في كل مرة.
وبيان الفرق بين كلمة من وبين كلمة كل فيما يرجع إلى الخصوص بما ذكره محمد في السير الكبير: إذا قال: من دخل هذا الحصن أولا فله كذا فدخل رجلان معا لم يكن لواحد منهما شئ، ولو قال: كل من دخل هذا الحصن أولا فله كذا فدخل عشرة معا استحق كل واحد منهم النفل تاما لاجل الاحاطة في كلمة كل على وجه الافراد، وكل واحد من الداخلين كأنه فرد ليس معه غيره وهو أول من الناس من الذين لم يدخلوا فاستحق النفل كاملا، ولو دخل العشرة على التعاقب كان النفل للاول خاصة في الفصلين لاحتمال الخصوص في كلمة كل، فإن الاول اسم لفرد سابق وهذا الوصف تحقق فيه دون من دخل بعده.
وكلمة الجميع بمنزلة كلمة كل في أنها توجب الاحاطة ولكن على وجه الاجتماع لا على وجه الافراد، حتى لو قال جميع من دخل منكم الحصن أولا فله كذا فدخل عشرة معا استحقوا نفلا واحدا، بخلاف قوله كل من دخل لان لفظ الجميع للاحاطة على وجه الاجتماع وهم سابقون بالدخول على سائر الناس، وكلمة كل للاحاطة على وجه الافراد، فكل واحد منهم كالمنفرد بالدخول سابقا على سائر الناس ممن لم يدخل، ولو قال جماعة من أهل الحرب آمنونا على بنينا ولاحدهم ابن وبنات وللباقين بنات فقط ثبت الامان لهم جميعا، ولو قال آمنوا كل واحد منا على بنيه فإنما الامان لاولاد الرجل الذي له ابن خاصة دون الآخرين، لان الاحاطة في الاول على وجه الاجتماع وباختلاط الذكر الواحد بجماعتهم بتناولهم اسم البنين، وفي الثاني الاحاطة على سبيل الافراد فإنما يتناول لفظ البنين أولاد الرجل الذي له ابن دون أولاد الذين لهم بنات فقط، وهذه الكلمات موضوعة لمعنى العموم لغة غير معلولة.
ونوع آخر منها النكرة فإن النكرة من الاسم للخصوص في أصل الوضع، لان
المقصود به تسمية فرد من الافراد.
قال الله تعالى: (إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا) والمراد رسول واحد، قال صلى الله عليه وسلم : في خمس من الابل شاة وفي العادة يقال عبد من العبيد ورجل من الرجال ولا يقال رجال من الرجال.
ثم هذه النكرة عند الاطلاق لا تعم عندنا، وعند الشافعي رحمه الله تكون عامة، وبيانه في قوله تعالى: (فتحرير رقبة) فهو يقول هذه رقبة عامة يدخل فيها الصغيرة والكبيرة والذكر والانثى والكافرة والمؤمنة والصحيحة والزمنة وقد خص منها الزمنة والمدبرة بالاجماع فيجوز تخصيص الكافرة منها بالقياس على كفارة القتل، ونحن نقول: هذه رقبة مطلقة غير مقيدة بوصف فالتقييد بالوصف يكون زيادة ولا يكون تخصيصا فيكون نسخا ورفعا لحكم الاطلاق إذ المقيد غير
المطلق، وبهذا النص وجب عتق رقبة لا عتق رقاب.
ثم جواز العتق في جميع ما ذكره باعتبار صلاحية المحل لما وجب بالامر، وهذه الصلاحية ما ثبتت بهذا النص فقد كانت صالحة للتحرير قبل وجوب العتق بهذا النص، وإنما الثابت بهذا النص الوجوب فقط وليس فيه معنى العموم، كمن نذر أن يتصدق بدرهم فأي درهم تصدق به خرج عن نذره، لان صلاحية المحل للتصدق لم تكن بنذره إنما الوجوب بالنذر وليس في الوجوب معنى العموم، واشتراط الملك في الرقبة لضرورة التحرير المنصوص عليه فإن التحرير لا يصح من المرء إلا في ملكه، واشتراط صفة السلامة لاطلاق الرقبة لان الاطلاق يقتضي الكمال والزمنة قائمة من وجه مستهلكة من وجه فلا تكون قائمة مطلقا حتى تتناولها اسم الرقبة مطلقا، ولهذا شرط كمال الرق أيضا لان التحرير منصوص عليه مطلقا وذلك إعتاق كامل ابتداء، وفي المدبر وأم الولد هذا من وجه تعجيل لما صار مستحقا لهما مؤجلا فلا يكون إعتاقا مبتدأ مطلقا، وعلى هذا قلنا: المنكر إذا أعيد منكرا فالثاني غير الاول، لان اسم النكرة يتناول فردا غير معين وفي صرف الثاني إلى ما يتناوله الاول نوع تعيين فلا يكون نكرة مطلقا، وهو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين، فإن الله تعالى ذكر اليسر منكرا وأعاده منكرا وذكر العسر معرفا بالالف واللام ولو كان إطلاق اسم النكرة يوجب العموم لم يكن الثاني غير الاول، فإن العام إذا أعيد بصيغته فالثاني
لا يتناول إلا ما يتناوله الاول بمنزلة اسم الجنس، وعلى هذا قال أبو حنيفة: إذا أقر بمائة درهم في موطن وأشهد شاهدين ثم أقر بمائة في موطن آخر وأشهد شاهدين كان الثاني غير الاول، ولو كتب صكا فيه إقرار بمائة وأشهد شاهدين في مجلس ثم شاهدين في مجلس آخر كان المال واحدا، لانه حين أضاف الاقرار إلى ما في الصك صار الثاني معرفا فيتناول ما يتناوله الاول فقط، كما في قوله تعالى: (فعصى فرعون الرسول)
ولو كان في مجلس واحد أقر مرتين فالمال واحد استحسانا، لان للمجلس تأثيرا في جمع الكلمات المتفرقة وجعلها ككلمة واحدة فباعتباره يكون الثاني معرفا من وجه، وقال أبو يوسف ومحمد في المجلسين كذلك باعتبار العادة، لان الانسان يكرر الاقرار الواحد بين يدي كل فريق من الشهود لمعنى الاستيثاق والمال مع الشك لا يجب فلاحتمال الاعادة بطريق العادة لم يلزمه إلا مال واحد.
ثم هذه النكرة تحتمل معنى العموم إذا اتصل بها دليل العموم، وذلك أنواع: منها النكرة في موضع النفي فإنها تعم، قال تعالى: (فلا تدعوا مع الله أحدا) والرجل يقول: ما رأيت رجلا اليوم فإنما يفهم منه نفي هذا الجنس على العموم وهذا التعميم ليس بصيغة النكرة بل لمقتضاها، وبه تبين معنى الفرق بين النكرة في الاثبات والنكرة في النفي، لان في موضع الاثبات المقصود إثبات المنكر وفي موضع النفي المقصود نفي المنكر، فالصيغة في الموضعين تعمل فيما هو المقصود إلا أن من ضرورة نفي رؤية رجل منكر نفي رؤية جنس الرجال، فإنه بعد رؤية رجل واحد لو قال ما رأيت اليوم رجلا كان كاذبا، ألا ترى أنه لو أخبر بضده فقال رأيت اليوم رجلا كان صادقا وليس من ضرورة إثبات رؤية رجل واحد إثبات رؤية غيره، فهذا معنى قولنا: النكرة في النفي تعم وفي الاثبات تخص.
ومما يدل على العموم في النكرة الالف واللام إذا اتصلا بنكرة ليس في جنسها معهود، قال تعالى: (إن الانسان لفي خسر) وقال تعالى: (والسارق والسارقة) وقال تعالى: *
(الزانية والزاني) لما اتصل الالف واللام بنكرة ليس في جنسها معهود أوجب العموم، ولهذا قلنا: لو قال المرأة التي أتزوجها طالق تطلق كل امرأة يتزوجها، ولو قال: العبد الذي يدخل الدار من عبيدي حر يعتق كل عبد يدخل الدار، وهذا لان الالف واللام للمعهود وليس هنا معهود فيكون بمعنى الجنس مجازا، كالرجل
يقول فلان يحب الدينار ومراده الجنس وفي الجنس معنى العموم كما بينا، وعلى هذا لو قال لامرأته أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق يحتمل معنى العموم فيه حتى إذا نوى الثلاث تقع الثلاث، ولكن بدون النية يتناول الواحدة لانها أدنى الجنس وهي المتيقن بها، وعلى هذا قال في الزيادات: لو وكل وكيلا بشراء الثياب يصح التوكيل بدون بيان الجنس، لان عند ذكر الالف واللام يصير هذا بمعنى الجنس فيتناول الادنى، بخلاف ما لو قال ثيابا أو أثوابا فإن التوكيل لا يكون صحيحا لجهالة الجنس فيما يتناوله التوكيل.
ومن الدليل على التعميم في النكرة إلحاق وصف عام بها حتى إذا قال: والله لا أكلم إلا رجلا عالما كان له أن يكلم كل عالم، لان المستثنى نكرة في الاثبات ولكنها موصوفة بصفة عامة، بخلاف ما لو قال إلا رجلا فكلم رجلين فإنه يحنث، ولو قال لامرأتين له والله لا أقربكما إلا يوما فالمستثنى يوم واحد، ولو قال إلا يوم أقربكما فيه فكل يوم يقربهما فيه يكون مستثنى لا يحنث به لانه وصف النكرة بصفة عامة.
ومن جنس النكرة كلمة أي فإنها للخصوص باعتبار أصل الوضع، يقول أي رجل أتاك وأي دار تريدها والمراد الفرد فقط، وقال تعالى: (أيكم يأتيني بعرشها) والمراد الفرد من المخاطبين بدليل قوله تعالى: (يأتيني) فإنه لم يقل يأتوني، وعلى هذا لو قال لرجل أي عبيدي ضربته فهو حر فضربهم لم يعتق إلا واحد منهم لان كلمة أي يتناول الفرد منهم.
فإن قيل: أليس أنه لو قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه عتقوا جميعا ؟ قلنا: نعم ولكن كلمة أي تتناول الفرد مما يقرن به من النكرة، فإذا قال ضربك فإنما يتناول نكرة موصوفة بفعل الضرب وهذه الصفة عامة فيتعمم بتعميم
الصفة فيعتقون جميعا، وإذا قال ضربته فإنما أضاف الضرب إلى المخاطب لا إلى النكرة
التي تتناولها كلمة أي فبقيت نكرة غير موصوفة فلهذا لا تتناول إلا الواحد منهم، ونظيره قوله تعالى: (أي الفريقين أحق بالامن) والمراد أحدهما بدليل قوله: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) وقال تعالى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) والمراد به العموم لانه وصف النكرة بحسن العمل وهي صفة عامة.
فإن قيل: أليس أنه لو قال لعبيده أيكم حمل هذه الخشبة فهو حر فحملوها جميعا معا والخشبة يطيق حملها واحد لم يعتق واحد منهم وقد وصف النكرة هنا بصفة عامة وهو الحمل ؟ قلنا: ما وصف النكرة بصفة الحمل مطلقا بل بحمل الخشبة وإذا حملوها معا فكل واحد منهم إنما حمل بعضها وبوجود بعض الشرط لا ينزل شئ من الجزاء حتى لو حملوها على التعاقب عتقوا جميعا، لان كل واحد منهم حمل الخشبة والنكرة الموصوفة تكون عامة.
فإن قيل: إذا كانت الخشبة بحيث لا يطيق حملها واحد منهم عتقوا جميعا إذا حملوها وإنما حمل كل واحد منهم بعضها ؟ قلنا: إذا كانت لا يطيق حملها واحد فقط علمنا أنه وصف النكرة بأصل الحمل لا بحمل الخشبة، وإنما علمنا هذا من وجهين: أحدهما أنه إنما يحث العبيد على ما يتحقق منهم دون ما لا يتحقق، والثاني أن مقصوده إذا كانت بحيث يحملها واحد معرفة جلادتهم وإنما يحصل ذلك بحمل الواحد الخشبة لا بمطلق الحمل، وإذا كانت بحيث لا يحملها واحد فمقصوده أن تصير الخشبة محمولة إلى موضع حاجته وإنما يحصل هذا بمطلق فعل الحمل من كل واحد منهم، فهذا وجه الفرق بين هذه الفصول.
فصل وأما حكم المشترك فالتوقف فيه إلى أن يظهر المراد بالبيان على اعتقاد أن ما هو المراد حق، ويشترط أن لا يترك طلب المراد به إما بالتأمل في الصيغة أو الوقوف على دليل آخر به يتبين المراد، لان كلام الحكيم لا يخلو عن فائدة، وإذا كان المشترك
ما يحتمل معاني على وجه التساوي في الاحتمال مع علمنا أن المراد واحد منها لا جميعها، فإن الاشتراك عبارة عن التساوي، وذلك إما في الاجتماع في التناول أو في احتمال التناول، وقد انتفى معنى التساوي في التناول فتعين معنى التساوي في الاحتمال ووجب اعتقاد الحقية فيما هو المراد لان ذلك فائدة كلام الحكيم، ثم يجب الاشتغال بطلبه، ولطلبه طريقان: إما التأمل بالصيغة ليتبين به المراد أو طلب دليل آخر يعرف به المراد، وبالوقوف على المراد يزول معنى الاحتمال على التساوي، فلهذا يجب ذلك بحكم الصيغة المشتركة، وبيان هذا في قوله: غصبت من فلان شيئا، فإن أصل الاقرار يصح ويجب به حق للمقر له على المقر إلا أن في اسم الشئ احتمالا في كل موجود على التساوي، ولكن بالتأمل في صيغة الكلام يعلم أن مراده المال لانه قال غصبت وحكم الغصب لا يثبت شرعا إلا فيما هو مال ولكن لا يعرف جنس ذلك المال ولا مقداره بالتأمل في صيغة الكلام فيرجع فيه إلى بيان المقر حتى يجبر على البيان ويقبل قوله إذا بين ما هو محتمل.
وأما حكم المؤول فوجوب العمل به على حسب وجوب العمل بالظاهر إلا أن وجوب العمل بالظاهر ثابت قطعا ووجوب العمل بالمؤول ثابت مع احتمال السهو والغلط فيه فلا يكون قطعا بمنزلة العمل بخبر الواحد لان طريقه غالب الرأي وذلك لا ينفك عن احتمال السهو والغلط، وبيان هذا فيمن أخذ ماء المطر في إناء فإنه يلزمه التوضؤ به ويحكم بزوال الحدث به قطعا، ولو وجد ماء في موضع فغلب على ظنه أنه طاهر يلزمه التوضؤ به على احتمال السهو والغلط حتى إذا تبين أن الماء نجس يلزمه إعادة الوضوء والصلاة، وأكثر مسائل التحري على هذا.
باب: أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها هذه الاسماء أربعة: الظاهر والنص والمفسر والمحكم، ولها أضداد أربعة:
الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه.
أما الظاهر فهو ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل، وهو الذي يسبق
إلى العقول والاوهام لظهوره موضوعا فيما هو المراد، مثاله قوله تعالى: (يأيها الناس اتقوا ربكم) وقال تعالى: (وأحل الله البيع) وقال تعالى: (فاقطعوا أيديهما) فهذا ونحوه ظاهر يوقف على المراد منه بسماع الصيغة، وحكمه لزوم موجبه قطعا عاما كان أو خاصا.
وأما النص فما يزداد وضوحا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة، وزعم بعض الفقهاء أن اسم النص لا يتناول إلا الخاص وليس كذلك، فإن اشتقاق هذه الكلمة من قولك: نصصت الدابة إذا حملتها على سير فوق السير المعتاد منها بسبب باشرته، ومنه المنصة فإنه اسم للعرش الذي يحمل عليه العروس فيزداد ظهورا بنوع تكلف، فعرفنا أن النص ما يزداد وضوحا لمعنى من المتكلم، يظهر ذلك عند المقابلة بالظاهر عاما كان أو خاصا، إلا أن تلك القرينة لما اختصت بالنص دون الظاهر جعل بعضهم الاسم للخاص فقط.
وقال بعضهم: النص يكون مختصا بالسبب الذي كان السياق له فلا يثبت به ما هو موجب الظاهر، وليس كذلك عندنا، فإن العبرة لعموم الخطاب لا لخصوص السبب عندنا على ما نبينه، فيكون النص ظاهرا لصيغة الخطاب نصا باعتبار القرينة التي كان السياق لاجلها، وبيان هذا في قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) فإنه ظاهر في إطلاق البيع نص في الفرق بين البيع والربا بمعنى الحل والحرمة، لان السياق كان لاجله، لانها نزلت ردا على الكفرة في دعواهم المساواة بين البيع والربا، كما قال تعالى: (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا) وقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) ظاهر في تجويز نكاح ما يستطيبه المرء من النساء نص في بيان
العدد، لان سياق الآية لذلك بدليل قوله تعالى: (مثنى وثلاث ورباع) وقوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) نص في الامر بمراعاة وقت السنة عند إرادة الايقاع، لان السياق كان لاجل ذلك ظاهر في الامر بأن لا يزيد على تطليقة واحدة (فإن امتثال هذه الصيغة يكون بقوله طلقت، وبهذا اللفظ لا يقع الطلاق إلا واحدة والامر موجب)
الامتثال ظاهرا، فتبين بهذا أن موجب النص ما هو موجب الظاهر ولكنه يزداد على الظاهر فيما يرجع إلى الوضوح والبيان بمعنى عرف من مراد المتكلم، وإنما يظهر ذلك عند المقابلة ويكون النص أولى من الظاهر.
وأما المفسر فهو اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفا على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل فيكون فوق الظاهر والنص، لان احتمال التأويل قائم فيهما منقطع في المفسر، سواء كان ذلك مما يرجع إلى صيغة الكلام بأن لا يكون محتملا إلا وجها واحدا ولكنه لغة عربية أو استعارة دقيقة فيكون مكشوفا ببيان الصيغة، أو يكون بقرينة من غير الصيغة، فيتبين به المراد بالصيغة لا لمعنى من المتكلم فينقطع به احتمال التأويل إن كان خاصا واحتمال التخصيص إن كان عاما، مثاله قوله تعالى: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) فإن اسم الملائكة عام فيه احتمال الخصوص فبقوله: (كلهم) ينقطع هذا الاحتمال ويبقى احتمال الجمع والافتراق فبقوله: (أجمعون) ينقطع احتمال تأويل الافتراق، وتبين أن المفسر حكمه زائد على حكم النص والظاهر فكان ملزما موجبه قطعا على وجه لا يبقى فيه احتمال التأويل، ولكن يبقى احتمال النسخ.
وأما المحكم فهو زائد على ما قلنا باعتبار أنه ليس فيه احتمال النسخ والتبديل، وهو مأخوذ من قولك: بناء محكم: أي مأمون الانتقاض، وأحكمت الصيغة: أي أمنت نقضها وتبديلها، وقيل بل هو مأخوذ من قول القائل: أحكمت فلانا عن
كذا: أي رددته، قال القائل: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا أي امنعوا، ومنه حكمة الفرس لانها تمنعه من العثار والفساد، فالمحكم ممتنع من احتمال التأويل، ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل، ولهذا سمى الله تعالى المحكمات أم الكتاب: أي الاصل الذي يكون المرجع إليه بمنزلة الام للولد فإنه يرجع إليها، وسميت مكة أم القرى لان الناس يرجعون إليها للحج وفي آخر الامر،
والمرجع ما ليس فيه احتمال التأويل ولا احتمال النسخ والتبديل، وذلك نحو قوله تعالى: (إن الله بكل شئ عليم) فقد علم أن هذا (وصف) دائم لا يحتمل السقوط بحال وإنما يظهر التفاوت في موجب هذه الاسامي عند التعارض، وفائدته ترك الادنى بالاعلى وترجيح الاقوى على الاضعف، ولهذا أمثلة في الآثار إذا تعارضت نذكرها في بيان أقسام الاخبار إن شاء الله تعالى.
وأمثاله من مسائل الفقه ما قال علماؤنا رحمهم الله فيمن تزوج امرأة شهرا فإنه يكون ذلك متعة لا نكاحا، لان قوله تزوجت نص للنكاح ولكن احتمال المتعة قائم فيه، وقوله شهرا مفسر في المتعة ليس فيه احتمال النكاح فإن النكاح لا يحتمل التوقيت بحال فإذا اجتمعا في الكلام رجحنا المفسر وحملنا النص على ذلك المفسر فكان متعة لا نكاحا.
وقال في الجامع: إذا قال الرجل لآخر لي عليك ألف درهم فقال الحق أو الصدق أو اليقين كان إقرارا ولو قال البر أو الصلاح لا يكون إقرارا، فإن قال البر الحق أو البر الصدق أو البر اليقين كان إقرارا، ولو قال الصلاح الحق أو الصلاح الصدق أو الصلاح اليقين يكون ردا لكلامه ولا يكون إقرارا، لان الحق والصدق واليقين صفة للخبر ظاهرا فإذا ذكره في موضع الجواب كان محمولا على الخبر الذي هو تصديق باعتبار الظاهر مع احتمال فيه وهو إرادة ابتداء الكلام، أي الصدق أولى بك أو الحق أو اليقين
أولى بالاشتغال من دعوى الباطل، فأما البر فهو اسم لجميع أنواع الاحسان لا يختص بالخبر فهو وإن ذكر في موضع الجواب يكون بمنزلة المجمل لا يفهم منه الجواب عند الانفراد، فإن قرن به ما يكون ظاهره للجواب وذلك الصدق أو الحق أو اليقين حمل ذلك المجمل على هذا البيان الظاهر فيكون إقرارا، فأما الصلاح ليس فيه احتمال الخبر بل هو محكم في أنه ابتداء كلام لا جواب، فيحمل ما يقرن به من الظاهر على هذا المحكم ويجعل ذلك ردا لكلامه وابتداء أمر له باتباع الصلاح وترك دعوى الباطل.
وأما الخفي فهو اسم لما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع نيل المراد بها إلا بالطلب، مأخوذ من قولهم: اختفى فلان إذا استتر في وطنه وصار بحيث لا يوقف عليه بعارض حيلة أحدثه إلا بالمبالغة في الطلب من غير أن يبدل نفسه أو موضعه، وهو ضد الظاهر، وقد جعل بعضهم ضد الظاهر المبهم وفسره بهذا المعنى أيضا، مأخوذ من قول القائل: ليل بهيم إذا عم الظلام فيه كل شئ حتى لا يهتدى فيه إلا بحد التأمل.
قال رضي الله عنه: ولكني اخترت الاول لان اسم المبهم يتناول المطلق لغة، تقول العرب: فرس بهيم: أي مطلق اللون.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أبهموا ما أبهم الله تعالى: أي أطلقوا ما أطلق الله تعالى ولا تقيدوا الحرمة في أمهات النساء بالدخول بالبنات.
وبيان ما ذكرنا من معنى الخفي في قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فإنه ظاهر في السارق الذي لم يختص باسم آخر سوى السرقة يعرف به، خفي في الطرار والنباش، فقد اختصا باسم آخر هو سبب سرقتهما يعرفان به، فاشتبه الامر أن اختصاصهما بهذا الاسم لنقصان في معنى السرقة أو زيادة فيها، ولاجل ذلك اختلف العلماء.
قال أبو يوسف اختصاص النباش باسم هو سبب سرقته لا يدل على نقصان في سرقته كالطرار، وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله السرقة اسم لاخذ المال
على وجه مسارقة عين حافظه مع كونه قاصدا إلى حفظه باعتراض غفلة له من نوم أو غيره، والنباش يسارق عين من عسى يهجم عليه ممن ليس بحافظ للكفن ولا قاصد إلى حفظه، فهو يبين أن اختصاصه بهذا الاسم لنقصان في معنى السرقة، وكذلك في اسم السرقة ما ينبئ عن خطر المسروق بكونه محرزا محفوظا، وفي اسم النباش ما ينفي هذا المعنى بل ينبئ عن ضده من الهوان وترك الاحراز، والتعدية في مثل هذا لايجاب العقوبة التي تدرأ بالشبهات باطلة، فأما الطرار فاختصاصه بذلك الاسم لزيادة حذق ولطف منه في جنايته، فإنه يسارق عين من يكون مقبلا على الحفظ قاصدا لذلك بفترة تعتريه في لحظة فذلك ينبئ عن مبالغة في جناية السرقة، وتعدية الحكم بمثله مستقيم في الحدود لانه إثبات حكم النص بطريق الاولى، بمنزلة حرمة الشتم والضرب بالنص المحرم للتأفيف.
ثم حكم الخفي اعتقاد الحقية في المراد ووجوب الطلب إلى أن يتبين المراد، وفوقه المشكل وهو ضد النص، مأخوذ من قول القائل: أشكل على كذا، أي دخل في أشكاله وأمثاله، كما يقال: أحرم، أي دخل في الحرم، وأشتى، أي دخل في الشتاء، وأشأم، أي دخل الشام، وهو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الاشكال، والمشكل قريب من المجمل ولهذا خفي على بعضهم فقالوا: المشكل والمجمل سواء ولكن بينهما فرق، فالتمييز بين الاشكال ليوقف على المراد قد يكون بدليل آخر وقد يكون بالمبالغة في التأمل حتى يظهر به الراجح، فيتبين به المراد، فهو من هذا الوجه قريب من الخفي ولكنه فوقه، فهناك الحاجة إلى التأمل في الصيغة وفي أشكالها، وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد، ثم الاقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين المراد فيعمل به.
وأما المجمل فهو ضد المفسر، مأخوذ من الجملة، وهو لفظ لا يفهم المراد منه
إلا باستفسار من المجمل وبيان من جهته يعرف به المراد، وذلك إما لتوحش في معنى الاستعارة أو في صيغة عربية مما يسميه أهل الادب لغة غريبة، والغريب اسم لمن فارق وطنه ودخل في جملة الناس فصار بحيث لا يوقف على أثره إلا بالاستفسار عن وطنه ممن يعلم به، وموجبه اعتقاد الحقية فيما هو المراد والتوقف فيه إلى أن يتبين ببيان المجمل ثم استفساره ليبينه، بمنزلة من ضل عن الطريق وهو يرجو أن يدركه بالسؤال ممن له معرفة بالطريق أو بالتأمل فيما ظهر له منه فيحتمل أن يدرك به الطريق.
وتبين أن المجمل فوق المشكل فإن المراد في المشكل قائم والحاجة إلى تمييزه من أشكاله، والمراد في المجمل غير قائم ولكن فيه توهم معرفة المراد بالبيان والتفسير وذلك البيان دليل آخر غير متصل بهذه الصيغة إلا أن يكون لفظ المجمل فيه غلبة الاستعمال لمعنى فحينئذ يوقف على المراد بذلك الطريق، بمنزلة الغريب الذي تأهل في غير بلدته وصار معروفا فيها فإنه يوقف على أثره بالطلب في ذلك الموضع.
وبيان ما ذكرنا من المجمل في قوله تعالى: (وحرم الربا) فإنه مجمل، لان الربا عبارة عن الزيادة في أصل الوضع وقد علمنا أنه ليس المراد ذلك، فإن البيع ما شرع إلا للاسترباح وطلب الزيادة،
ولكن المراد حرمة البيع بسبب فضل خال عن العوض مشروط في العقد، وذلك فضل مال أو فضل حال على ما يعرف في موضعه، ومعلوم أن بالتأمل في الصيغة لا يعرف هذا بل بدليل آخر فكان مجملا فيما هو المراد، وكذلك الصلاة والزكاة فهما مجملان، لان الصيغة في أصل الوضع للدعاء والنماء ولكن بكثرة الاستعمال شرعا في أعمال مخصوصة يوقف على المراد بالتأمل فيه.
وأما المتشابه فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه عليه، والحكم فيه اعتقاد الحقية والتسليم بترك الطلب، والاشتغال بالوقوف على المراد منه، سمي متشابها عند بعضهم لاشتباه الصيغة بها وتعارض المعاني فيها وهذا غير صحيح، فالحروف
المقطعة في أوائل السور من المتشابهات عند أهل التفسير وليس فيها هذا المعنى ولكن معرفة المراد فيه ما يشبه لفظه وما يجوز أن يوقف على المراد فيه وهو بخلاف ذلك، لانقطاع احتمال معرفة المراد فيه وأنه ليس له موجب سوى اعتقاد الحقية فيه والتسليم كما قال تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله) فالوقف عندنا في هذا الموضع، ثم قوله تعالى: (والراسخون في العلم) ابتداء بحرف الواو لحسن نظم الكلام، وبيان أن الراسخ في العلم من يؤمن بالمتشابه ولا يشتغل بطلب المراد فيه بل يقف فيه مسلما هو معنى قوله تعالى: (يقولون آمنا به كل من عند ربنا) وهذا لان المؤمنين فريقان: مبتلي بالامعان في الطلب لضرب من الجهل فيه، ومبتلي عن الوقوف في الطلب لكونه مكرما بنوع من العلم.
ومعنى الابتلاء من هذا الوجه ربما يزيد على معنى الابتلاء في الوجه الاول، فإن في الابتلاء بمجرد الاعتقاد مع التوقف في الطلب بيان أن مجرد العقل لا يوجب شيئا ولا يدفع شيئا، فإنه يلزمه اعتقاد الحقية فيما لا مجال لعقله فيه ليعرف أن الحكم لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهذا هو المعنى في الابتلاء بهذه الاسامي التي فيها تفاوت يعني المجمل والمشكل والخفي، فإن الكل لو كان ظاهرا جليا بطل معنى الامتحان ونيل الثواب بالجهد بالطلب، ولو كان الكل مشكلا خفيا لم يعلم منه شئ حقيقة فأثبت الشرع هذا التفاوت في صيغة الخطاب
لتحقيق معنى الامتحان، وإظهار فضيلة الراسخين في العلم وتعظيم حرمتهم، وصرف القلوب إلى محبتهم، لحاجتهم إلى الرجوع إليهم، والاخذ بقولهم والاقتداء بهم.
وبيان ما ذكرنا من معنى المتشابه من مسائل الاصول أن رؤية الله تعالى بالابصار في الآخرة حق معلوم ثابت بالنص، وهو قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) ثم هو موجود بصفة الكمال، وفي كونه مرئيا لنفسه ولغيره معنى الكمال إلا أن الجهة ممتنع، فإن الله تعالى لا جهة له فكان متشابها فيما يرجع إلى كيفية
الرؤية والجهة مع كون أصل الرؤية ثابتا بالنص معلوما كرامة للمؤمنين، فإنهم أهل لهذه الكرامة، والتشابه فيما يرجع إلى الوصف لا يقدح في العلم بالاصل ولا يبطل، وكذلك الوجه واليد على ما نص الله تعالى في القرآن معلوم، وكيفية ذلك من المتشابه فلا يبطل به الاصل المعلوم.
والمعتزلة - خذلهم الله - لاشتباه الكيفية عليهم أنكروا الاصل فكانوا معطلة بإنكارهم صفات الله تعالى، وأهل السنة والجماعة - نصرهم الله - أثبتوا ما هو الاصل المعلوم بالنص وتوقفوا فيما هو المتشابه وهو الكيفية، فلم يجوزوا الاشتغال بطلب ذلك كما وصف الله تعالى به الراسخين في العلم فقال: (يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الالباب) .
فصل: في بيان الحقيقة والمجاز الحقيقة اسم لكل لفظ هو موضوع في الاصل لشئ معلوم، مأخوذ من قولك: حق يحق فهو حق وحاق وحقيق، ولهذا يسمى أصلا أيضا لانه أصل فيما هو موضوع له.
والمجاز اسم لكل لفظ هو مستعار لشئ غير ما وضع له، مفعل من جاز يجوز سمي مجازا لتعديه عن الموضع الذي وضع في الاصل له إلى غيره، ومنه قول الرجل لغيره: حبك إياي مجاز: أي هو باللسان دون القلب الذي هو موضع الحب في الاصل، وهذا الوعد منك مجاز: أي القصد منه الترويج دون التحقيق على ما عليه وضع الوعد في الاصل، ولهذا يسمى مستعارا، لان المتكلم به استعاره وبالاستعمال فيما هو مراده بمنزلة من استعار ثوبا للبس ولبسه، وكل واحد من النوعين موجود في كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الناس في الخطب والاشعار وغير ذلك،
حتى كاد المجاز يغلب الحقيقة لكثرة الاستعمال، وبه اتسع اللسان وحسن مخاطبات الناس بينهم.
وحكم الحقيقة وجود ما وضع له أمرا كان أو نهيا خاصا كان أو عاما، وحكم
المجاز وجود ما استعير لاجله كما هو حكم الحقيقة خاصا كان أو عاما.
ومن أصحاب الشافعي رحمه الله من قال لا عموم للمجاز، ولهذا قالوا إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء لا يعارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين فإن المراد بالصاع ما يكال به وهو مجاز لا عموم له، وبالاجماع المطعوم مراد به فيخرج ما سواه من أن يكون مرادا، ويترجح قوله عليه السلام: لا تبيعوا الطعام بالطعام لانه حقيقة في موضعه فيثبت الحكم به عاما، واستدلوا لاثبات هذه القاعدة بأن المصير إلى المجاز لاجل الحاجة والضرورة، فأما الاصل هو الحقيقة في كل لفظ لانه موضوع له في الاصل، ولهذا لا يعارض المجاز الحقيقة بالاتفاق حتى لا يصير اللفظ في المتردد بين الحقيقة والمجاز في حكم المشترك، وهذه الضرورة ترتفع بدون إثبات حكم العموم للمجاز فكان المجاز في هذا المعنى بمنزلة ما ثبت بطريق الاقتضاء، فكما لا تثبت هناك صفة العموم لان الضرورة ترتفع بدونه فكذلك ها هنا.
ولكنا نقول المجاز أحد نوعي الكلام فيكون بمنزلة نوع آخر في احتمال العموم والخصوص لان العموم للحقيقة ليس باعتبار معنى الحقيقة بل باعتبار دليل آخر دل عليه، فإن قولنا رجل اسم لخاص فإذا قرن به الالف واللام وليس هناك معهود ينصرف إليه بعينه كان للجنس فيكون عاما بهذا الدليل، وكذا كل نكرة إذا قرن بها الالف واللام فيما لا معهود فيه يكون عاما بهذا الدليل وقد وجد هذا الدليل في المجاز، والمحل الذي استعمل فيه المجاز قابل للعموم فتثبت به صفة العموم بدليله كما ثبت في الحقيقة، ولهذا جعلنا قوله: (ولا الصاع بالصاعين) عاما، لان الصاع نكرة قرن بها الالف واللام، وما يحويه الصاع محل لصفة العموم، وهذا
لان المجاز مستعار ليكون قائما مقام الحقيقة عاملا عمله ولا يتحقق ذلك إلا بإثبات
صفة العموم فيه، ألا ترى أن الثوب الملبوس بطريق العارية يعمل عمل الملبوس بطريق الملك فيما هو المقصود وهو دفع الحر والبرد، ولو لم يجعل كذلك لكان المتكلم بالمجاز عن اختيار مخلا بالغرض فيكون مقصرا وذلك غير مستحسن في الاصل، وقد ظهر استحسان الناس للمجازات والاستعارات فوق استحسانهم للفظ الذي هو حقيقة، عرفنا أنه ليس في هذه الاستعارة تقصير فيما هو المقصود وأن للمجاز من العمل ما للحقيقة، وقولهم إن المجاز يكون للضرورة باطل، فإن المجاز موجود في كتاب الله تعالى والله تعالى يتعالى عن أن يلحقه العجز أو الضرورة، إلا أن التفاوت بين الحقيقة والمجاز في اللزوم والدوام من حيث إن الحقيقة لا تحتمل النفي عن موضعها والمجاز يحتمل ذلك وهو العلامة في معرفة الفرق بينهما فإن اسم الاب حقيقة للاب الادنى فلا يجوز نفيه عنه بحال، وهو مجاز للجد حتى يجوز نفيه عنه بأن يقال إنه جد وليس بأب، ولهذا تترجح الحقيقة عند التعارض، لانها ألزم وأدوم والمطلوب بكل كلمة عند الاطلاق ما هي موضوعة له في الاصل فيترجح ذلك حتى يقوم دليل المجاز، بمنزلة الملبوس يترجح جهة الملك للابس فيه حتى يقوم دليل العارية إلا إذا كانت الحقيقة مهجورة فحينئذ يتعين المجاز لمعرفة القصد إلى تصحيح الكلام وينزل ذلك منزلة دليل الاستثناء، ولهذا قلنا لو حلف أن لا يأكل من هذه الشجرة أو من هذا القدر لا ينصرف يمينه إلى عينها وإنما ينصرف إلى ثمرة الشجرة وما يطبخ في القدر، لان الحقيقة مهجورة فيتعين المجاز.
ولو حلف لا يأكل من هذه الشاة ينصرف يمينه إلى لحمها لا إلى لبنها وسمنها، لان الحقيقة هنا غير مهجورة فإن عين الشاة تؤكل فتترجح الحقيقة على المجاز عند إطلاق اللفظ.
ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فقد قال بعض مشايخنا يحنث إذا أكل الدقيق بعينه، لانه مأكول، والاصح أنه لا يحنث لان أكل عين الدقيق مهجور فينصرف يمينه إلى المجاز وهو ما يتخذ منه الخبز، وصار دليل الاستثناء بهذا الدليل نحو دليل الاستثناء فيمن
حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فأخذ في النقلة في الحال فإنه لا يحنث
ويصير ذلك القدر من السكنى مستثنى لمعرفة مقصوده وهو أن يمنع نفسه بيمينه عما في وسعه دون ما ليس في وسعه، وعلى هذا لو حلف لا يطلق وقد كان علق الطلاق بشرط قبل هذه اليمين فوجد الشرط لم يحنث، أو كان حلف بعد الجرح أن لا يقتل فمات المجروح لم يحنث، ويجعل ذلك بمنزلة دليل الاستثناء بمعرفة مقصوده.
ومن أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يجتمعان في لفظ واحد في حالة واحدة على أن يكون كل واحد منهما مرادا بحال، لان الحقيقة أصل والمجاز مستعار ولا تصور لكون اللفظ الواحد مستعملا في موضوعه مستعارا في موضع آخر سوى موضوعه في حالة واحدة، كما لا تصور لكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في وقت واحد، ولهذا قلنا في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) المراد الجماع دون اللمس باليد، لان الجماع مراد بالاتفاق حتى يجوز التيمم للجنب بهذا النص، ولا تجتمع الحقيقة والمجاز مرادا باللفظ، فإذا كان المجاز مرادا تتنحى الحقيقة، ولهذا قلنا النص الوارد في تحريم الخمر وإيجاب الحد بشربه بعينه لا يتناول سائر الاشربة المسكرة حتى لا يجب الحد بها ما لم تسكر، لان الاسم للنئ من ماء العنب المشتد حقيقة ولسائر الاشربة المسكرة مجازا، فإذا كانت الحقيقة مرادا يتنحى المجاز، وعلى هذا الاصل قال أبو حنيفة رحمه الله فيمن أوصى لبني فلان أو لاولاد فلان وله بنون لصلبه وأولاد البنين فإن أولاد البنين لا يستحقون شيئا، لان الحقيقة مرادة فيتنحى المجاز.
وقال في السير: إذا استأمنوا على آبائهم لا يدخل أجدادهم في ذلك، وإذا استأمنوا على أمهاتهم لا تدخل الجدات في ذلك، لان الحقيقة مرادة فيتنحى المجاز، وعلى هذا قال في الجامع: لو أن عربيا لا ولاء عليه أوصى لمواليه وله معتقون ومعتق المعتقين فإن الوصية لمعتقه وليس لمعتق المعتق شئ،
لان الاسم للمعتقين حقيقة باعتبار أنه باشر سبب إحيائهم بإحداث قوة المالكية فيهم بالاعتاق، لان الحرية حياة والرق تلف حكما فكانوا منسوبين
إليه بالولاء حقيقة كنسبة الولد إلى أبيه، وأما معتق المعتق يسمى مولى له مجازا، لانه بالاعتاق الاول جعله بحيث يملك اكتساب سبب الولاء وهو الاعتاق فيكون متسببا في الولاء الثاني من هذا الوجه، ويسمى مولى له مجازا بطريق الاتصال من حيث السببية، فإذا صارت الحقيقة مرادا يتنحى المجاز، حتى لو لم يكن له معتقون فالوصية لموالي الموالي، لان الحقيقة هنا غير مرادة فيتعين المجاز، ولو كان له معتق واحد والوصية بلفظ الجماعة فاستحق هو نصف الثلث كان الباقي مردودا على الورثة ولا يكون لموالي الموالي من ذلك شئ، لان الحقيقة هنا مرادة ولو كان للموصي موال أعلى وأسفل لم تصح الوصية، لان الاسم مشترك وكل واحد من الفريقين يحتمل أن يكون مرادا إلا أنه لا وجه للجمع بينهما وإثبات العموم لاختلاف المعنى والمقصود فيبطل أصل الوصية، ومعلوم أن التغاير بين الحقيقة والمجاز باعتبار أصل الوضع وفي الاسم المشترك لا تغاير باعتبار أصل الوضع، ثم لم يجز هناك أن يكون كل واحد منهما مرادا باللفظ في حالة واحدة فلان لا يجوز ذلك في الحقيقة والمجاز أولى.
فإن قيل: هذا الاصل لا يستمر في المسائل فإن من حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان يحنث إذا دخلها ماشيا كان أو راكبا حافيا كان أو منتعلا، وحقيقة وضع القدم فيها إذا كان حافيا.
وكذلك لو قال: يوم يقدم فلان فامرأته كذا فقدم ليلا أو نهارا يقع الطلاق والاسم للنهار حقيقة ولليل مجاز.
ولو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا يسكنها فلان عارية أو بأجر يحنث كما لو دخل دارا مملوكة له.
وفي السير قال: لو استأمن على بنيه يدخل بنوه وبنو بنيه، ولو استأمن على مواليه وهو ممن لا ولاء
عليه يدخل في الامان مواليه وموالي مواليه، فقد جمعتم بين الحقيقة والمجاز في هذه الفصول.
وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا قال لله علي أن أصوم رجب ونوى به اليمين كان نذرا ويمينا واللفظ للنذر حقيقة ولليمين مجاز.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا حلف أن لا يشرب من الفرات فأخذ الماء من الفرات في كوز فشربه يحنث كما لو كرع في الفرات، ولو حلف
لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها يحنث كما لو أكل عينها وفي هذا جمع بين الحقيقة والمجاز في اللفظ في حالة واحدة.
قلنا: جميع هذه المسائل تخرج مستقيما على ما ذكرنا من الاصل عند التأمل، فقد ذكرنا أن المقصود معتبر وأنه ينزل ذلك منزلة دليل الاستثناء.
ففي مسألة وضع القدم مقصود الحالف الامتناع من الدخول فيصير باعتبار مقصوده كأنه حلف لا يدخل والدخول قد يكون حافيا وقد يكون منتعلا وقد يكون راكبا فعند الدخول حافيا يحنث لا باعتبار حقيقة وضع القدم بل باعتبار الدخول الذي هو المقصود، فعرفنا أنه إنما يحنث في المواضع كلها لعموم المجاز لا لعموم الحقيقة.
وكذلك قوله يوم يقدم فلان فالمقصود بذكر اليوم هنا الوقت، لانه قرن به ما هو غير ممتد ولا يختص ببياض النهار، واليوم إنما يكون عبارة عن بياض النهار إذا قرن بما يمتد ليصير معيارا له، حتى إذا قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم ليلا لا يصير الامر بيدها، وكذلك إذا قرن بما يختص بالنهار كقوله لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فأما إذا قرن بما لا يمتد ولا يختص بأحد الوقتين يكون عبارة عن الوقت، كما في قوله تعالى: (ومن يولهم يومئذ دبره) واسم الوقت يعم الليل والنهار فلعموم المجاز قلنا بأنها تطلق في الوجهين جميعا، حتى إذا قال ليلة يقدم فلان فقدم نهارا لم تطلق لان الحقيقة هنا مرادة فيتنحى المجاز.
وفي مسألة دخول دار فلان المقصود إضافة السكنى وذلك يعم السكنى بطريق الملك والعارية، وإذا دخل دارا يسكنها فلان بالملك إنما يحنث لعموم المجاز لا للملك، حتى لو كان
الساكن فيها غير فلان لم يحنث وإن كانت مملوكة لفلان.
وفي مسألتي السير قياس واستحسان في القياس يتنحى المجاز في الامان كما في الوصية، وفي الاستحسان قال: المقصود من الامان حقن الدم وهو مبني على التوسع واسم الابناء والموالي من حيث الظاهر يتناول الفروع إلا أن الحقيقة تتقدم على المجاز في كونه مرادا، ولكن مجرد الصورة تبقى شبهته في حقن الدم كما ثبت الامان بمجرد الاشارة من الفارس إذا دعا الكافر بها إلى نفسه لصورة المسالمة وإن لم يكن ذلك حقيقة.
فإن قيل: لماذا لم تعتبر هذه الصورة في إثبات الامان للاجداد والجدات عند
الاستئمان على الآباء والامهات ؟ قلنا: لان الحقيقة إذا صارت مرادا فاعتبار هذه الصورة لثبوت الحكم في محل آخر يكون بطريق التبعية لا محالة، وبنو البنين وموالي الموالي تليق صفة التبعية بحالهم، فأما الاجداد والجدات لا يكونون تبعا للآباء والامهات وهم الاصول، فلهذا ترك اعتبار الصورة هناك في إثبات الامان لهم، فأما مسألة النذر فقد قيل معنى النذر هناك يثبت بلفظ ومعنى اليمين بلفظ آخر، فإن قوله لله عند إرادة اليمين كقوله بالله إذ الباء واللام تتعاقبان، قال ابن عباس رضي الله عنهما: دخل آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج، وقوله علي نذر ونحن إنما أنكرنا اجتماع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد مع أن تلك الكلمة نذر بصيغتها يمين بموجبها إذا أراد اليمين، لان موجبها وجوب المنذور به، وإيجاب المباح يمين كتحريم الحلال المباح وهو نظير شراء القريب تملك بصيغته وإعتاق بموجبه.
وأما مسألة الشرب من الفرات فالحنث عندها باعتبار عموم المجاز، لان المقصود شرب ماء الفرات ولا تنقطع هذه النسبة بجعل الماء في الاناء وعند الكرع إنما يحنث لانه شرب ماء الفرات، حتى لو تحول من الفرات إلى نهر آخر لم يحنث إن شرب منه، لان النسبة قد انقطعت عن الفرات بالتحول إلى نهر آخر.
وأبو حنيفة رحمه الله
اعتبر الحقيقة قال: الشرب من الفرات حقيقة معتادة غير مهجورة وإنما يتناول هذا اللفظ الماء بطريق المجاز عن قولهم جرى النهر أي الماء فيها، وإذا صارت الحقيقة مرادا يتنحى المجاز، وكذلك في مسألة الحنطة أبو حنيفة اعتبر الظاهر فقال عين الحنطة مأكول وهو مراد مقصود فيتنحى المجاز، وهما جعلا ذكر الحنطة عبارة عما في باطنها مجازا للعرف، فإنه يقال أهل بلدة كذا يأكلون الحنطة والمراد ما فيها من عين الحنطة وإنما يحنث لعموم المجاز وهو أنه تناول ما فيها وهذا موجود فيما إذا أكل من خبزها، فخرجت المسائل على هذا الحرف وهو اعتبار عموم المجاز بمعرفة المقصود لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز.
قال رضي الله عنه: وقد رأيت بعض العراقيين من أصحابنا رحمهم الله قالوا: إن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان في لفظ واحد في محل واحد ولكن في محلين مختلفين يجوز أن يجتمعا، وهذا قريب بشرط أن لا يكون المجاز مزاحما للحقيقة مدخلا للجنس على صاحب الحقيقة، فإن الثوب الواحد على اللابس يجوز أن يكون نصفه ملكا ونصفه عارية، وقد قلنا في قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) إنه يتناول الجدات وبنات البنات والاسم للام حقيقة وللجدات مجاز، وكذلك اسم البنات لبنات الصلب حقيقة ولاولاد البنات مجاز، وكذلك في قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) فإنه موجب حرمة منكوحة الجد كما يوجب حرمة منكوحة الاب، فعرفنا أنه يجوز الجمع بينهما في لفظ واحد ولكن في محلين مختلفين حتى يكون حقيقة في أحدهما مجازا في المحل الآخر، وهذا بخلاف المشترك فالاحتمال هناك باعتبار معاني مختلفة ولا تصور لاجتماع تلك المعاني في كلمة واحدة، وهنا تجمع الحقيقة والمجاز في احتمال الصيغة لكل واحد منهما معنى واحدا وهو الاصالة في الآباء والاجداد والامهات والجدات والولاد في حق الاولاد ولكن بعضها بواسطة وبعضها
بغير واسطة، فيكون هذا نظير ما قال أبو حنيفة رحمه الله في قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) إنه يتناول جميع أجناس الارض باعتبار معنى يجمع الكل وهو التصاعد من الارض وإن كان الاسم للتراب حقيقة.
وبيان الفرق بين المشترك وبين المجاز مع الحقيقة في المعنى الذي ذكرنا فيما قال في السير: لو استأمن لمواليه وله موال أعلى وأسفل فالامان لاحد الفريقين وهو ما أراده الذي آمنه، وإن لم يرد شيئا يأمن الفريقان باعتبار أن الامان يتناول أحدهما لا باعتبار أنه يتناولهما، لان الاسم مشترك، وبمثله لو كان له موال وموالي موال ثبت الامان للفريقين جميعا باعتبار أنه يجوز أن يكون اللفظ الواحد عاملا بحقيقته في موضع وبمجازه في موضع آخر.
ثم طريق معرفة الحقيقة السماع لان الاصل فيه الوضع ولا يصير ذلك معلوما إلا بالسماع بمنزلة المنصوص في أحكام الشرع، وطريق الوقوف عليها السماع فقط.
وإنما طريق معرفة المجاز الوقوف على مذهب العرب في الاستعارة دون السماع بمنزلة القياس في أحكام الشرع، فإن طريق تعدية حكم النص إلى الفروع معلوم وهو التأمل في معاني النص واختيار الوصف المؤثر منها لتعدية الحكم بها إلى الفروع، فإذا وقف مجتهد على ذلك وأصاب طريقه كان ذلك مسموعا منه وإن لم يسبق به، فكذلك في الاستعارة إذا وقف إنسان على معنى تجوز الاستعارة به عند العرب فاستعار بذلك المعنى واستعمل لفظا في موضع كان مسموعا منه وإن لم يسبق به، وعلى هذا يجري كلام البلغاء من الخطباء والشعراء في كل وقت.
فنقول: طريق الاستعارة عند العرب الاتصال، والاتصال بين الشيئين يكون صورة أو معنى، فإن كل موجود متصور تكون له صورة ومعنى، فالاتصال لا يكون إلا باعتبار الصورة أو باعتبار المعنى.
فأما الاستعارة للاتصال معنى فنحو تسمية العرب الشجاع أسدا للاتصال بينهما في معنى الشجاعة والقوة، والبليد حمارا لاتصال
بينهما في معنى البلادة، والاستعارة للاتصال صورة نحو تسمية العرب المطر سماء، فإنهم يقولون: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم يعنون المطر، لانها تنزل من السحاب والعرب تسمي كل ما علا فوقك سماء ويكون نزول المطر من علو فسموه سماء مجازا للاتصال صورة، وقال تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) والغائط اسم للمطمئن من الارض، وسمي الحدث به مجازا لان يكون في المطمئن من الارض عادة، وهذا اتصال من حيث الصورة، وقال تعالى: (أو لامستم النساء) والمراد الجماع لان اللمس سببه صورة فسماه به مجازا وقال تعالى: (إني أراني أعصر خمرا) (وإنما يعصر العنب وهو مشتمل على السفل والماء والقشر إلا أنه بالعصر يصير خمرا) في أوانه فسماه به مجازا لاتصال بينهما في الذات صورة، فسلكنا في الاسباب الشرعية والعلل هذين الطريقين في الاستعارة وقلنا يصح الاستعارة للاتصال سببا فإنه نظير الاستعارة للاتصال صورة في المحسوسات، وللاتصال في المعنى المشروع الذي جاء لاجله شرع يصلح الاستعارة، وهو نظير الاتصال معنى في المحسوسات فإنه لا خلاف بين العلماء
أن صلاحية الاستعارة غير مختص بطريق اللغة وأن الاتصال في المعاني والاحكام الشرعية يصلح للاستعارة، وهذا لان الاستعارة للقرب والاتصال وذلك يتحقق في المحسوس وغير المحسوس، فالاحكام الشرعية قائمة بمعناها متعلقة بأسبابها فتكون موجودة حكما بمنزلة الموجود حسا فيتحقق معنى القرب والاتصال فيها، ولان المشروعات إذا تأملت في أسبابها وجدتها دالة على الحكم المطلوب بها باعتبار أصل اللغة فيما تكون معقولة المعنى والكلام فيه ولا استعارة فيما لا يعقل معناه، ألا ترى أن البيع مشروع لايجاب الملك وموضوع له أيضا في اللغة، وقد اتفق العلماء في جواز استعارة لفظ التحرير لايقاع الطلاق به، وجوز الشافعي رحمه الله استعارة لفظ الطلاق لايقاع العتق به، والائمة من السلف استعملوا الاستعارة بهذا الطريق أيضا وكتاب
الله تعالى ناطق بذلك، يعني قوله تعالى: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها) فإن الله تعالى جعل هبتها نفسها جوابا للاستنكاح وهو طلب النكاح، ولا خلاف أن نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينعقد بلفظ الهبة على سبيل الاستعارة لا على سبيل حقيقة الهبة، فإن الهبة لتمليك المال فلا يكون عاملا بحقيقتها فيما ليس بمال، ولانها لا توجب الملك إلا بالقبض فيما كانت حقيقة فيه فكيف فيما ليست بحقيقة فيه، فعرفنا أنها استعارة قامت مقام النكاح بطريق المجاز، وكذلك كان يتعلق بنكاحه حكم القسم والطلاق والعدة وإن كان معقودا بلفظ الهبة، فعرفنا أنه كان بطريق الاستعارة على معنى أن اللفظ متى صار مجازا عن غيره سقط اعتبار حقيقته وصار التكلم به كالتكلم بما هو مجاز عنه.
ثم ليس للرسالة أثر في معنى الخصوصية بوجوه الكلام، فإن معنى الخصوصية هو التخفيف والتوسعة وما كان يلحقه حرج في استعمال لفظ النكاح فقد كان أفصح الناس، وهذه جملة لا خلاف فيها، إلا أن الشافعي رحمه الله قال نكاح غيره لا ينعقد بهذا اللفظ لانه عقد مشروع لمقاصد لا تحصى مما يرجع إلى مصالح الدين والدنيا، ولفظ النكاح والتزويج يدل على ذلك باعتبار أنها تبتنى على الاتحاد، فالتزويج تلفيق بين الشيئين على وجه يثبت به الاتحاد بينهما في المقصود كزوجي الخف ومصراعي الباب، والنكاح
بمعنى الضم الذي ينبئ عن الاتحاد بينهما في القيام بمصالح المعيشة، وليس في هذين اللفظين ما يدل على التمليك باعتبار أصل الوضع، ولهذا لا يثبت ملك العين بهما، فالالفاظ الموضوعة لايجاب ملك العين فيها قصور فيما هو المقصود بالنكاح، إلا أن في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينعقد نكاحه بهذا اللفظ مع قصور فيه تخفيفا عليه وتوسعة للغات عليه، كما قال تعالى: (خالصة لك) وفي حق غيره لا يصلح هذا اللفظ لانعقاد النكاح به لما فيه من القصور، وهو معنى ما يقولون:
إنه عقد خاص شرع بلفظ خاص.
ونظيره الشهادة فإنها مشروعة بلفظ خاص فلا تصلح بلفظ آخر لقصور فيه حتى إذا قال الشاهد أحلف لا يكون شهادة لان لفظ الحلف موجب بغيره ولفظ الشهادة موجب بنفسه، قال تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو) وكذلك لفظ الهبة لا تنعقد به المعاوضة المحضة وهي البيع ابتداء وكأن ذلك لقصور فيها، وفي صفة المعاوضة النكاح أبلغ من البيع، وعلى هذا الاصل لم يجوزوا نقل الاخبار بالمعنى من غير مراعاة اللفظ، ولكنا نقول: النكاح موجب ملك المتعة، وهذه الالفاظ في محل ملك المتعة توجب ملك المتعة تبعا لملك الرقبة فإنها توجب ملك الرقبة وملك الرقبة يوجب ملك المتعة في محله فكان بينهما اتصالا من حيث السببية وهو طريق صالح للاستعارة، ولا حاجة إلى النية لان هذا المحل الذي أضيف إليه متعين لهذا المجاز وهو النكاح، والحاجة إلى النية عند الاشتباه للتعيين، وما ذكروا من مقاصد النكاح فهي لكونها غير محصورة بمنزلة الثمرة كما هو المطلوب من هذا العقد، فأما المقصود فإثبات الملك عليها ولهذا وجب البدل لها عليه، فلو كان المقصود ما سواها من المقاصد لم يجب البدل لها عليه، لان تلك المقاصد مشتركة بينهما، وكذلك جعل الطلاق بيد الزوج لانه هو المالك فإليه إزالة الملك، وإذا ثبت أن المقصود هو الملك وهذه الالفاظ موضوعة لايجاب الملك، ثم لما انعقد هذا العقد بلفظ غير موضوع لايجاب ما هو المقصود وهو الملك، فلان
ينعقد بلفظ موضوع لايجاب ما هو المقصود وهو الملك كان أولى، وإنما انعقد هذا العقد بلفظ النكاح والتزويج وإن لم يوضعا لايجاب الملك بهما في الاصل لانهما جعلا علما في إثبات هذا الملك بهما وما يكون علما لشئ بعينه فهو بمنزلة النص فيه فيثبت الحكم به بعينه ولهذا لم ينعقد بهما الاسباب الموجبة لملك العين، فأما الالفاظ الموضوعة لايجاب الملك لا ينتفي باسم العلم عن هذا المحل، وقد تقرر صلاحية الاستعارة
بالاتصال من حيث السببية فيثبت هذا الملك بها بطريق الاستعارة.
فإن قيل: الاتصال من حيث السببية لا يختص بأحد الجانبين بل يكون من الجانبين جميعا ثم لم يعتبر هذا الاتصال والقرب في إثبات ملك الرقبة باللفظ الذي هو موضوع لايجاب ملك المتعة، فكذلك لا يعتبر هذا الاتصال لاثبات ملك المتعة باللفظ الموضوع لاثبات ملك الرقبة.
قلنا: الاتصال من حيث السببية نوعان: أحدهما اتصال الحكم بالعلة وذلك معتبر في صلاحية الاستعارة من الجانبين، لان العلة غير مطلوبة لعينها بل لثبوت الحكم بها، والحكم لا يثبت بدون العلة فيتحقق معنى القرب والاتصال لافتقار كل واحد منهما إلى الآخر.
وبيان هذا فيما قال في الجامع: إذا قال: إن ملكت عبدا فهو حر فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى النصف الثاني لا يعتق، فإن قال: عنيت الملك متفرقا كان أو مجتمعا يدين في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى ويعتق النصف الباقي في ملكه.
ولو قال: إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصفه فباعه ثم اشترى النصف الباقي يعتق هذا النصف، فإن قال: عنيت الشراء مجتمعا يدين فيما بينه وبين الله تعالى فلا يعتق هذا النصف، وقيل الشراء موجب للملك والملك حكم الشراء فيصلح أن يكون ذكر الملك مستعارا عن ذكر الشراء إذا نوى التفرق فيه، ويصلح أن يكون ذكر الشراء مستعارا عن ذكر الملك إذا نوى الاجتماع فيه حتى يعمل بنيته من حيث الديانة في الموضعين، ولكن فيما فيه تخفيف عليه لا يدين في القضاء للتهمة، وفيما فيه تشديد عليه يدين لانتفاء التهمة.
والنوع الآخر اتصال الفرع بالاصل والحكم بالسبب، فإن بهذا الاتصال تصلح استعارة الاصل للفرع والسبب للحكم، ولا تصلح استعارة الفرع للاصل
والحكم للسبب، لان الاصل مستغن عن الفرع والفرع محتاج إلى الاصل، لانه تابع له فيصير معنى الاتصال معتبرا فيما هو محتاج إليه دون ما هو مستغنى عنه.
وهو نظير الجملة الناقصة إذا عطفت على الجملة الكاملة، فإنه يعتبر اتصال الجملة الناقصة بالكاملة فيما يرجع إلى إكمال الناقصة لحاجتها إلى ذلك حتى يتوقف أول الكلام على آخره ولا يعتبر اتصال الناقص بالكامل في حكم الكامل لانه مستغنى عنه، فملك الرقبة سبب ملك المتعة بينهما اتصال من هذا الوجه فلهذا جاز استعارة السبب للحكم ولا يجوز استعارة الحكم للسبب، واللفظ الموضوع لايجاب ملك الرقبة يجوز أن يستعار لايجاب ملك المتعة، والموضوع لايجاب ملك المتعة لا يصلح مستعارا لايجاب ملك الرقبة، ولهذا الطريق قلنا إن لفظ التحرير عامل في إيقاع الطلاق به مجازا لانها موضوعة لازالة ملك الرقبة، وزوالها سبب لزوال ملك المتعة إلا أنه لا يعمل بدون النية، لان المحل المضاف إليه غير متعين لهذا المجاز، بل هو محل لحقيقة الوصف بالحرية فيحتاج إلى النية ليتعين فيها الاستعمال بطريق المجاز، ولفظ الطلاق لا يحصل به العتق لانه موضوع لازالة ملك المتعة، وزوال ملك المتعة ليس بسبب لزوال ملك الرقبة، بل هو حكم ذلك السبب فلا يصلح استعارة الحكم للسبب كما لا يصلح استعارة الفرع للاصل لكونه مستغنى عنه، ولكن الشافعي رحمه الله جوز هذه الاستعارة أيضا للقرب بينهما من حيث المشابهة في المعنى وكل واحد منهما إزالة بطريق الابطال مبني على الغلبة، والسراية غير محتمل للفسخ محتمل للتعليق بالشرط والايجاب في المجهول فللمناسبة بينهما في هذا المعنى جوز استعارة كل واحد منهما للآخر، ولكنا نقول: المناسبة في المعنى صالح للاستعارة لكن لا بكل وصف بل بالوصف الذي يختص بكل واحد منهما، ألا ترى أنه لا يسمى الجبان أسدا ولا الشجاع حمارا للمناسبة بينهما من حيث الحيوانية والوجود وما أشبه ذلك، ويسمى الشجاع أسدا للمناسبة بينهما في الوصف الخاص وهو الشجاعة، وهذا لان اعتبار هذه المناسبة بينهما للاستعارة بمنزلة اعتبار المعنى في المنصوص لتعدية الحكم به إلى الفروع، ثم لا يستقيم تعليل النص بكل وصف
بل بوصف له أثر في ذلك الحكم، لانه لو جوز التعليل بكل وصف انعدم معنى الابتلاء أصلا، فكذلك ههنا لو صححنا الاستعارة للمناسبة في أي معنى كان ارتفع معنى الامتحان واستوى العالم والجاهل، فعرفنا أنه إنما تعتبر المناسبة في الوصف الخاص ولا مناسبة هنا في الوصف الذي لاجله وضع كل واحد منهما في الاصل، فالطلاق موضوع للاطلاق برفع المانع من الانطلاق لا بإحداث قوة الانطلاق في الذات، ومنه إطلاق الابل وإطلاق الاسير والعتاق لاحداث معنى في الذات يوجب القوة، من قول القائل: عتق الفرخ إذا قوي حتى طار، وفي ملك اليمين المملوك عاجز عن الانطلاق لضعف في ذاته وهو أنه صار رقيقا مملوكا مقهورا محتاجا إلى إحداث قوة فيه يصير بها مالكا مستوليا مستبدا بالتصرف، والمنكوحة مالكة أمر نفسها ولكنها محبوسة عند الزوج بالملك الذي له عليها فحاجتها إلى رفع المانع وذلك يكون بالطلاق كما يكون برفع القيد عن الاسير وبحل العقال عن البعير، ولا مناسبة بين رفع المانع وبين إحداث القوة، كما لا مناسبة بين رفع القيد وبين البرء من المرض، فعرفنا أنه لا وجه للاستعارة بطريق المناسبة بينهما في المعنى ولكن بالاتصال من حيث السببية والحكم، وقد بينا أن ذلك صالح من أحد الجانبين دون الجانب الآخر.
فإن قيل: عندكم الاجازة لا تنعقد بلفظ البيع نص عليه في كتاب الصلح حيث قال: بيع السكنى باطل، فالبيع سبب لملك الرقبة وملك الرقبة سبب لملك المنفعة.
ثم لم تصح الاستعارة بهذا الطريق عندكم مجازا، وعلى عكس هذا إذا قال لغيره أعتق عبدك عني على ألف درهم فقال أعتقت يثبت التملك شراء بهذا الكلام والعتق ليس بسبب للشراء ثم كان عبارة عنه مجازا، وكذلك شراء القريب إعتاق عندكم والشراء ليس بسبب العتق ثم كان عبارة عنه.
قلنا: أما استعمال لفظ البيع في الاجارة
فإنما لا يجوز عندنا لانعدام المحل لا لانعدام الصلاحية للاستعارة، لانه إن أضيف لفظ البيع إلى رقبة الدار والعبد فهو عامل بحقيقته في تمليك العين، وإن أضيف إلى
منفعتهما فالمنفعة معدومة والمعدوم لا يكون محلا للتمليك، واللفظ متى صار مجازا عن غيره يجعل كأنه وجد التصريح باللفظ الذي هو مجاز عنه.
ولو قال: أجرتك منافع هذه الدار لا يصح أيضا وإنما يصح إذا قال أجرتك الدار باعتبار إقامة العين المضاف إليه العقد مقام المنفعة، ولفظ البيع متى أضيف إلى العين كان عاملا في حقيقته حتى لو قال الحر لغيره: بعتك نفسي شهرا بعشرة يجوز ذلك على وجه الاستعارة عن الاجارة، لان عين الحر ليس بمحل لما وضع له البيع حقيقة، وأهل المدينة يسمون الاجارة بيعا فتجوز ههنا الاستعارة للاتصال من حيث السببية، وأما قوله أعتق عبدك عني فمن يقول إن ذلك مجاز عن الشراء فقد أخطأ خطأ فاحشا وكيف يكون ذلك مجازا عنه وهو عامل بحقيقته واللفظ متى صار مجازا عن غيره يسقط اعتبار حقيقته ؟ وفي الموضع الذي لا يثبت حقيقة العتق بأن يكون القائل صبيا أو عبدا مأذونا لا يثبت الشراء، فعرفنا أن ثبوت الشراء هناك بطريق الاقتضاء للحاجة إلى تحصيل المقصود الذي صرحنا به وهو الاعتاق عنه فإن من شرطه ثبوت الملك له في المحل والمقتضى ليس من المجاز في شئ، وكذلك شراء القريب عندنا ليس بإعتاق مجازا، وكيف يكون ذلك وهو عامل بحقيقته وهو ثبوت الملك به ولا يجمع بين الحقيقة والمجاز في محل واحد ؟ بل بطريق أن الشراء موجب ملك الرقبة وملك الرقبة متمم علة العتق في هذا المحل، فيصير الحكم وهو العتق مضافا إلى السبب الموجب لما تتم به العلة بطريق أنه بمنزلة علة العلة، فأما أن يكون بطريق المجاز فلا.
ومن أحكام هذا الفصل أن اللفظ متى كان له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف، فعلى قول أبي حنيفة مطلقه يتناول الحقيقة المستعملة دون المجاز، وعلى قولهما مطلقه
يتناولهما باعتبار عموم المجاز.
وبيانه فيما قلنا إذا حلف لا يشرب من الفرات أو لا يأكل من هذه الحنطة، وهذا في الحقيقة يبتني على أصل وهو أن المجاز عندهما خلف عن الحقيقة في إيجاب الحكم فهو المقصود لا نفس العبارة، وباعتبار الحكم يترجح عموم المجاز على الحقيقة فإن الحكم به يثبت في الموضعين، وعند أبي حنيفة المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم به لا في الحكم، لانه تصرف من المتكلم في عبارته من حيث إنه يجعل عبارته قائمة مقام عبارة، ثم الحكم يثبت به أصلا بطريق أنه
يجعل كالمتكلم بما كان المجاز عبارة عنه لا أنه خلف عن الحكم، وإذا كان المجاز خلفا في التكلم لا يثبت المزاحمة بين الاصل والخلف فيجعل اللفظ عاملا في حقيقته عند الامكان وإنما يصار إلى إعماله بطريق المجاز في الموضع الذي يتعذر إعماله في حقيقته.
وعلى هذا الاصل قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني يعتق عليه، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يعتق، لان صريح كلامه محال والمجاز عندهما خلف عن الحقيقة في إيجاب الحكم ففي كل موضع يصلح أن يكون السبب منعقدا لايجاب الحكم الاصلي يصلح أن يكون منعقدا لايجاب ما هو خلف عن الاصل، وفي كل موضع لا يوجد في السبب صلاحية الانعقاد للحكم الاصلي لا ينعقد موجبا لما هو خلف عنه، فإن قوله لامس السماء يصلح منعقدا لايجاب ما هو الاصل وهو البر من حيث إن السماء غير ممسوسة فيصلح أن يكون منعقدا لايجاب الخلف عنه وهو الكفارة، واليمين الغموس لا تصلح سببا لايجاب ما هو الاصل وهو البر فلا يكون موجبا لما هو خلف عنه وهو الكفارة، فهنا أيضا هذا اللفظ في معروف النسب الذي يولد مثله لمثله يصلح سببا لايجاب ما هو الاصل وهو ثبوت النسب إلا أنه امتنع إعماله (للحكم) لثبوت نسبه من الغير فيكون موجبا لما هو خلف عنه وهو العتق، وفيمن هو أكبر سنا منه لا يصلح
سببا لايجاب ما هو الاصل فلا يكون موجبا لما هو خلف عنه، ولهذا لا تصير أم الغلام أم الولد له هنا، وفي معروف النسب تصير أم ولد له على ما نص في كتاب الدعوى، وعلى هذا جعلنا بيع الحرة نكاحا، لان هناك المانع من الحكم الذي هو أصل في هذا المحل شرعي وهو تأكد الحرية على وجه لا يحتمل الابطال لا باعتبار أن السبب ليس بصالح لاثبات الحكم الاصلي به في هذا المحل فيكون منعقدا لاثبات ما هو خلف عنه وهو ملك المتعة، ولكن أبو حنيفة يقول المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم لا في الحكم كما قررنا، فالشرط فيه أن يكون الكلام صالحا وصلاحيته بكونه مبتدأ وخبرا بصيغة الايجاب وهو موجود هنا فيكون عاملا في إيجاب الحكم الذي يقبله هذا المحل بطريق المجاز على معنى أنه سبب للتحرير، فإن من ملك ولده يعتق عليه
ويصير معتقا له إذا اكتسب سبب تملكه، فاللفظ متى صار عبارة عن غيره مجازا للاتصال من حيث السببية يسقط اعتبار حقيقته، وباعتبار مجازه ما صادف إلا محلا صالحا، ولما تبين أنه خلف في التكلم لا في الحكم كان عمله كعمل الاستثناء والاستثناء صحيح على أن يكون عبارة عما وراء المستثنى وإن لم يصادف أصل الكلام محلا صالحا له باعتبار أنه تصرف من المتكلم في كلامه، حتى لو قال لامرأته أنت طالق ألفا إلا تسعمائة وتسعة وتسعين لم تقع إلا واحدة، نص عليه في المنتقى، ومعلوم أن المحل غير صالح لما صرح به ومع ذلك كان الاستثناء صحيحا لانه تصرف من المتكلم في كلامه فهنا كذلك.
ثم فيه طريقان لابي حنيفة: أحدهما أنه بمنزلة التحرير ابتداء باعتبار أنه ذكر كلاما هو سبب للتحرير في ملكه وهو البنوة فيصير محررا (به) ابتداء مجازا، ولهذا لا تصير الام أم ولد له لانه ليس لتحرير الغلام ابتداء تأثير في إيجاب أمية الولد (لامه) ولانه لا يملك إيجاب ذلك الحق لها بعبارته على الحقيقة ابتداء بل بفعل هو استيلاد، ولهذا قال في كتاب الدعوى: لو ورث رجلان مملوكا ثم ادعى أحدهما أنه ابنه يصير
ضامنا لشريكه قيمة نصيبه إذا كان موسرا باعتبار أن ذلك كالتحرير المبتدأ منه، وعلى الطريق الآخر يجعل هذا إقرارا منه بالحرية مجازا كأنه قال عتق علي من حين ملكته فإن ما صرح به وهو البنوة سبب لذلك وهنا هو الاصح، فقد قال في كتاب الاكراه إذا أكره على أن يقول هذا ابني لا يعتق عليه، والاكراه إنما يمنع صحة الاقرار بالعتق لا صحة التحرير ابتداء، ووجوب الضمان في مسألة الدعوى بهذا الطريق أيضا فإنه لو قال عتق علي من حين ملكته كان ضامنا لشريكه أيضا، وعلى هذا الطريق نقول: الجارية تصير أم ولد له لان كلامه كما جعل إقرارا بالحرية للولد جعل إقرارا بأمية الولد للام، فإن ما تكلم به سبب موجب هذا الحق لها في ملكه كما هو موجب حقيقة الحرية للولد، وبهذا الطريق في معروف النسب يثبت العتق لا بالطريق
الذي قالا، فإنه مكذب شرعا في الحكم الاصلي والمكذب في كلامه شرعا كالمكذب حقيقة في إهدار كلامه، ألا ترى أنه لو أكره على أن يقول لعبده هذا ابني لا يعتق عليه لانه مكذب شرعا بدليل الاكراه إلا أن دليل التكذيب هناك عامل في الحقيقة والمجاز جميعا، وهنا دليل التكذيب وهو ثبوت نسبه من الغير عامل في الحقيقة دون المجاز وهو الاقرار بحريته من حين ملكه، ولهذا قلنا: لو قال لزوجته وهي معروفة النسب من غيره هذه ابنتي لا تقع الفرقة بينهما لانه ليس بكلام موجب بطريق الاقرار في ملكه إنما موجبه إثبات النسب وقد صار مكذبا فيه شرعا فصار أصل كلامه لغوا.
وبيان هذا أن التبعية لا توجب الفرقة ولكنها تنافي النكاح أصلا، واللفظ متى صار مجازا عن غيره يجعل قائما مقام ذلك اللفظ فكأنه قال ما تزوجتها أو ما كان بيني وبينها نكاح قط، وذلك لا يوجب الفرقة، وكذلك لا يثبت به حرمتها عليه على وجه ينتفي به النكاح، لان في حكم الحرمة هذا الاقرار عليها لا على نفسه والعين هي التي تتصف بالحرمة وهو مكذب شرعا في إقراره على
غيره.
ولا يدخل على هذا ما إذا قال لعبده يا ابني لان النداء لاستحضار المنادي بصورته لا بمعناه وإنما صار هذا اللفظ مجازا باعتبار معناه كما بينا، فأما إذا قال يا حر أو يا عتيق فإعمال ذلك اللفظ باعتبار أنه علم لاسقاط الرق به لا باعتبار المعنى فيه فكان عاملا على أي وجه أضافه إلى المملوك، والله أعلم.
فصل: في بيان الصريح والكناية الصريح هو كل لفظ مكشوف المعنى والمراد حقيقة كان أو مجازا، يقال: فلان صرح بكذا، أي أظهر ما في قلبه لغيره من محبوب أو مكروه بأبلغ ما أمكنه من العبارة، ومنه سمي القصر صرحا، قال تعالى: (وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا) والكناية بخلاف ذلك وهو ما يكون المراد به مستورا إلى أن يتبين بالدليل، مأخوذ من قولهم: كنيت وكنوت، ولهذا كان الصريح ما يكون مفهوم المعنى بنفسه، وقد تكون الكناية ما لا يكون مفهوم المعنى بنفسه، فإن الحرف الواحد يجوز أن
يكون كناية نحو هاء الغائبة وكاف المخاطبة، يقول الرجل هو يفعل كذا، وهذا الهاء لا يميز اسما من اسم فتكون هذه الكناية من الصريح بمنزلة المشترك من المفسر، وكذلك كل اسم هو ضمير نحو أنا وأنت ونحن فهو كناية، وكل ما يكون متردد المعنى في نفسه فهو كناية، والمجاز قبل أن يصير متعارفا بمنزلة الكناية أيضا لما فيه من التردد، ومنه أخذت الكنية فإنها غير الاسم.
والاسم الصريح لكل شخص ما جعل علما له، ثم يكنى بالنسبة إلى ولده فيكون ذلك تعريفا له بالولد الذي هو معروف بالنسب إليه، وهذا ليس من المجاز في شئ ولكن لما كان معرفة المراد منه بغيره سمي كنية، وعلى هذا الاستعارات والتعريضات في الكلام بمنزلة الكناية فإن العرب تكني الحبشي بأبي البيضاء، والضرير بأبي العيناء، وليس بينهما اتصال بل بينهما مضادة، وقد ذكرنا أن المجاز حده الاتصال بينه وبين ما جعل مجازا عنه.
عرفنا أن الكناية غير المجاز ولكنهم يكنون بالشئ عن الشئ على وجه السخرية أو على وجه التفاؤل فيكنون عما يذم بما يمدح به على سبيل التفاؤل كما يذكرون صيغة الامر على وجه الزجر والتهديد، ويقولن تربت يداك على وجه التعطف، فبهذا يتبين أن حد الكناية غير حد المجاز.
ثم حكم الصريح ثبوت موجبه بنفسه من غير حاجة إلى عزيمة، وذلك نحو لفظ الطلاق والعتاق فإنه صريح فعلى أي وجه أضيف إلى المحل من نداء أو وصف أو خبر كان موجبا للحكم، حتى إذا قال يا حر أو يا طالق أو أنت حر أو أنت طالق أو قد حررتك أو قد طلقتك يكون إيقاعا نوى أو لم ينو لان عينه قائم مقام معناه في إيجاب الحكم لكونه صريحا فيه.
وحكم الكناية أن الحكم بها لا يثبت إلا بالنية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال، لان في المراد بها معنى التردد فلا تكون موجبة للحكم ما لم يزل ذلك التردد بدليل يقترن بها، وعلى هذا سمى الفقهاء لفظ التحريم والبينونة من كنايات الطلاق وهو مجاز عن التسمية باعتبار معنى التردد فيما يتصل به هذا اللفظ حتى لا يكون عاملا
إلا بالنية، فسمي كناية من هذا الوجه مجازا، فأما إذا انعدم التردد بنية الطلاق فاللفظ عامل في حقيقة موجبه حتى يحصل به الحرمة والبينونة، ومعلوم أن ما يكون كناية عن غيره فإن عمله كعمل ما جعل كناية عنه، ولفظ الطلاق لا يوجب الحرمة والبينونة بنفسه، فعرفنا أنه عامل بحقيقته وإنما سمي كناية مجازا إلا قوله اعتدي فإنه كناية لاحتماله وجوها متغايرة وعند إرادة الطلاق لا يكون اللفظ عاملا في حقيقته، فإن حقيقته من باب العد والحساب وذلك محتمل عدد الاقراء وغير ذلك، فإذا نوى الطلاق وكان بعد الدخول وقع الطلاق بمقتضاه من حيث إن الاحتساب بعدد الاقراء من العدة لا يكون إلا بعد الطلاق فكأنه صرح بالطلاق، ولهذا كان الواقع رجعيا ولا يقع به أكثر من واحدة وإن نوى، وإن كان قبل الدخول يقع الطلاق به عند
النية على أنه لفظ مستعار للطلاق شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة اعتدي ثم راجعها، وقال لحفصة اعتدي ثم راجعها، وكذلك قوله استبرئي رحمك، وكذلك قوله أنت واحدة فإن في قوله واحدة احتمال كونه نعتا لها أو للتطليقة فلا يتعين بدون النية وعند النية يقع الطلاق به بطريق الاضمار، أي أنت طالق تطليقة واحدة، ولهذا كان الواقع به رجعيا.
ثم الاصل في الكلام الصريح لانه موضوع للافهام، والصريح هو التام في هذا المراد فإن الكناية فيها قصور باعتبار الاشتباه فيما هو المراد، ولهذا قلنا: إن ما يندرئ بالشبهات لا يثبت بالكناية، حتى إن المقر على نفسه ببعض الاسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح كالزنا والسرقة لا يصير مستوجبا للعقوبة وإن ذكر لفظا هو كناية، ولهذا لا تقام هذه العقوبات على الاخرس عند إقراره به بإشارته لانه لم يوجد التصريح بلفظه، وعند إقامة البينة عليه لانه ربما يكون عنده شبهة لا يتمكن من إظهارها في إشارته، وعلى هذا لو قذف رجل رجلا بالزنا فقال له رجل آخر صدقت فإن الثاني لا يستوجب الحد، لان ما يلفظ به كناية عن القذف لاحتمال مطلق التصديق وجوها مختلفة، وكذلك لو قال لغيره أما أنا فلست بزان لا يلزمه حد القذف لانه تعريض وليس بتصريح بنسبته إلى الزنا فيكون قاصرا في نفسه.
فإن قيل: أليس أنه لو قذف رجل رجلا بالزنا فقال آخر هو كما قلت فإن الثاني يستوجب الحد وهذا تعريض محتمل أيضا ؟ قلنا: نعم ولكن كاف التشبيه توجب العموم عندنا في المحل الذي يحتمله، ولهذا قلنا في قول علي رضي الله عنه: إنما أعطيناهم الذمة وبدلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا: إنه مجرى على العموم فيما يندرئ بالشبهات وما يثبت مع الشبهات، فهذا الكاف أيضا موجبه العموم، لانه حصل في محل يحتمله، فيكون نسبته إلى الزنا قطعا بمنزلة كلام الاول على
ما هو موجب العام عندنا.
فصل: في بيان جملة ما تترك به الحقيقة وهي خمسة أنواع: أحدها دلالة الاستعمال عرفا، والثاني دلالة اللفظ.
والثالث سياق النظم، والرابع دلالة من وصف المتكلم، والخامس من محل الكلام.
فأما الاول فنقول: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال عرفا، لان الكلام موضوع للافهام والمطلوب به ما تسبق إليه الاوهام، فإذا تعارف الناس استعماله لشئ عينا كان ذلك بحكم الاستعمال كالحقيقة فيه وما سوى ذلك - لانعدام العرف - كالمهجور لا يتناوله إلا بقرينة، ألا ترى أن اسم الدراهم عند الاطلاق يتناول نقد البلد لوجود العرف الظاهر في التعامل به ولا يتناول غيره إلا بقرينة لترك التعامل به ظاهرا في ذلك الموضع وإن لم يكن بين النوعين فرق فيما وضع الاسم له حقيقة.
وبيان هذا في اسم الصلاة فإنها للدعاء حقيقة، قال القائل: وصلي على دنها وارتسم وهي مجاز للعبادة المشروعة بأركانها، سميت به لانها شرعت للذكر، قال تعالى: (وأقم الصلاة لذكري) وفي الدعاء ذكر وإن كان يشوبه سؤال، ثم عند الاطلاق ينصرف إلى العبادة المعلومة بأركانها سواء كان فيها دعاء أو لم يكن كصلاة الاخرس وإنما تركت الحقيقة للاستعمال عرفا.
وكذلك الحج فإن اللفظ للقصد
حقيقة ثم سميت العبادة بها لما فيها من العزيمة والقصد للزيارة فعند الاطلاق الاسم يتناول العبادة للاستعمال عرفا، والعمرة والصوم والزكاة وغيرها على هذا فإن نظائر هذا أكثر من أن تحصى، ولهذا قلنا من نذر صلاة أو حجا أو مشيا إلى بيت الله يلزمه العبادة وإن لم ينو ذلك، فالمشي إلى بيت الله تعالى غير الحج حقيقة ولكن للاستعمال عرفا ينصرف مطلق اللفظ إليه.
وكذلك لو قال لله علي أن أضرب بثوبي
حطيم الكعبة يلزمه التصدق بالثوب للاستعمال عرفا، فاللفظ حقيقة في غير ذلك.
ومن حلف أن لا يشتري رأسا ينصرف يمينه إلى ما يتعارف بيعه في الاسواق من الرؤوس على حسب ما اختلفوا فيه وكان ذلك للاستعمال عرفا، فأما من حيث الحقيقة الاسم يتناول كل رأس.
ومن حلف أن لا يأكل بيضا يتناول يمينه بيض الدجاج والاوز خاصة لاستعمال ذلك عند الاكل عرفا، ولا يتناول بيض الحمام والعصفور وما أشبه ذلك، وقد بينا أن العام إذا خص منه شئ يصير شبيه المجاز.
وبيان النوع الثاني وهو دلالة اللفظ فيما إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل لحم السمك أو الجراد لم يحنث في يمينه، لانه أطلق اللحم في لفظه ولحم السمك (أو الجراد) لا يذكر إلا بقرينة فكان قاصرا فيما يتناوله اسم مطلق اللحم، بمنزلة الصلاة على الجنازة فإنه قاصر فيما يتناوله مطلق اسم الصلاة من حيث إنه لا يذكر إلا بالقرينة، فلا يتناوله الاسم بدون القرينة.
فإن قيل: أليس أنه لو أكل لحم خنزير أو لحم إنسان فإنه يحنث في يمينه وهذا لا يذكر إلا بقرينة ؟ قلنا: نعم ولكن ذكر القرينة هنا ليس لقصور معنى اللحمية فيهما، فإن اللحم اسم معنوي موضوع لما يتولد من الدم ولا قصور في ذلك في لحم الخنزير والآدمي، فأما لحم السمك والجراد فإنه قاصر في ذلك المعنى، لانه لا دم للسمك ولا للجراد، فكذلك معنى الغذاء المطلوب باللحم لا يتم بالسمك والجراد.
فعرفنا أن القرينة فيها للقصور، ومعنى الغذاء المطلوب باللحم يتم في لحم
الخنزير والآدمي، فعرفنا أن القرينة لبيان الحرمة لا لقصور في معنى اللحمية، وليس للحرمة تأثير في المنع من إتمام شرط الحنث، وعلى هذا قلنا في قوله كل مملوك لي حر لا يدخل المكاتب بدون النية لانه تلفظ بالمملوك والمكاتب متردد بين كونه مالكا وبين كونه مملوكا فإنه مالك يدا وتصرفا مملوك رقا، وكذلك صرح بالاضافة إليه
والمكاتب مضاف إليه من وجه دون وجه، فللدلالة في لفظه لا يتناوله الكلام بدون النية ولكن يتناوله مطلق اسم الرقبة المذكورة في قوله: (أو تحرير رقبة) لانه يتناول الذات المرقوق، والرق لا ينتقض بعقد الكتابة بدليل احتمالها الفسخ واشتراط الملك بقدر ما يصح به التحرير وذلك موجود في المكاتب فيتأدى به الكفارة.
وكذلك قوله كل امرأة له طالق لا يتناول المختلعة بغير نية وإن كانت في العدة من غير النية لبقاء ملك اليد وزوال أصل ملك النكاح، وعلى عكس ما ذكرنا من معنى القصور معنى الزيادة أيضا، فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: من حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبا أو رطبا أو رمانا لم يحنث، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يحنث لان اسم الفاكهة يتناولها عند الاطلاق من غير قرينة فتكون كاملة في المعنى المطلوب بهذا الاسم، وأبو حنيفة رحمه الله يقول هي زيادة على ما هو المطلوب بالاسم لان اشتقاق اللفظ من التفكه وهو التنعم، قال تعالى: (انقلبوا فاكهين) : أي منعمين والتنعم زائد على ما به القوام، والرطب والعنب قوت يقع به القوام، والرمان في معنى الدواء وقد يقع به القوام أيضا وهو قوت في جملة التوابل وما يقع به القوام فهو زائد على التنعم، ولهذا عطف الله تعالى الفاكهة عليها وقال (وعنبا) إلى قوله: (وفاكهة وأبا) فللزيادة لا يتناولها مطلق الاسم كما أن للنقصان لا يتناول مطلق الاسم للسمك والجراد.
وكذلك لو حلف لا يأكل إداما، عند أبي حنيفة رحمه الله الادام ما يصطبغ به لانه تبع فلا يتناول ما يتأتى أكله مقصودا من الجبن والبيض واللحم، وعلى قول محمد رحمه الله يتناول ذلك لكمال معنى المؤادمة وهي الموافقة فيها كما في المسألة الاولى، وعن أبي يوسف رحمه الله روايتان في هذه المسألة.
وبيان النوع الثالث، وهو سياق النظم في قوله تعالى: (فمن شاء فليؤمن
ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا) فإن بسياق النظم يتبين أن المراد هو الزجر
والتوبيخ دون الامر والتخيير، وكذلك قوله تعالى: (اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير) فإن بسياق النظم يتبين أنه ليس المراد ما هو موجب صيغة الامر بهذه الصفة.
وعلى هذا لو أقر وقال: لفلان علي ألف درهم إن شاء الله لم يلزمه شئ، ولو قال: لفلان علي ألف درهم ليس له علي شئ إن شاء الله تلزمه الالف، لان قوله ليس رجوع وصيغة قوله إن شاء الله صيغة التعليق، والارسال والتعليق كل واحد منهما متعارف بين أهل اللسان فكان ذلك من باب البيان لا من باب الرجوع ووجوب المال عليه من حكم إرسال الكلام فمع صيغة التعليق لا يلزمه حكم الارسال باعتبار سياق النظم.
وقال في السير الكبير: لو قال مسلم لحربي محصور انزل فنزل كان آمنا، ولو قال انزل إن كنت رجلا فنزل كان فيئا، ولو قال له الحربي المأسور في يده الامان الامان وقال المسلم في جوابه الامان الامان كان آمنا حتى لو أراد قتله بعد هذا فعلى أمراء الجيش أن يمنعوه من ذلك ولا يصدقونه في قوله أردت رد كلامه، ولو قال الامان الامان ستعلم ما تلقى أو قال الامان الامان تطلب أو قال لا تعجل حتى ترى لم يكن ذلك أمانا بدلالة سياق النظم.
وكذلك لو قال لغيره اصنع في مالي ما شئت إن كنت رجلا أو قال طلق زوجتي إن كنت رجلا لم يكن توكيلا.
ولو قال لغيره: لي عليك ألف درهم فقال الآخر لك علي ألف درهم ما أبعدك من ذلك لم يكن إقرارا.
فعرفنا أن بدليل سياق النظم تترك الحقيقة.
وبيان النوع الرابع: في قوله تعالى: (واستفزز من استطعت منهم بصوتك) فإن كل واحد يعلم بأنه ليس بأمر لانه لا يجوز أن يظن ظان بأن الله تعالى يأمر بالكفر بحال، فتبين بأن المراد الاقدار والامكان لعلمنا أن ما يأتي به اللعين يكون بإقدار الله تعالى عليه إياه، وكذلك قول القائل اللهم اغفر لي يعلم أنه سؤال لا أمر لوصف المتكلم وهو أن العبد المحتاج إلى نعمة مولاه لا يطلب منه النعمة إلزاما وإنما يسأله ذلك سؤالا، وعلى هذا قلنا إذا قال لغيره تعال
تغد عندي فقال والله لا أتغدى ثم رجع إلى بيته فتغدى لا يحنث لان المتكلم دعاه إلى الغداء الذي بين يديه وقد أخرج كلامه مخرج الجواب، فإذا تقيد الخطاب بالمعلوم من إرادة المتكلم يتقيد الجواب أيضا به.
وكذلك لو قامت امرأة لتخرج فقال لها إن خرجت فأنت طالق فرجعت ثم خرجت بعد ذلك اليوم لم تطلق، وعلى هذا لو قالت له زوجته إنك تغتسل في هذه الدار الليلة من الجنابة فقال إن اغتسلت فعبدي حر ثم اغتسل فيها في (غير) تلك الليلة أو في تلك الليلة من غير الجنابة لم يحنث.
وبيان النوع الخامس: في قوله تعالى: (وما يستوي الاعمى والبصير) فإن بدلالة محل الكلام يعلم أنه ليس المراد نفي المساواة بينهما على العموم بل فيما يرجع إلى البصر فقط، وقد قلنا إن لفظ العموم في غير المحل القابل للعموم يكون بمعنى المجمل فلا يثبت به إلا ما يتيقن أنه مراد به ويكون ذلك شبه المجاز لدلالة محل الكلام، وعلى هذا قال علماؤنا رحمهم الله في قوله عليه السلام: الاعمال بالنيات وفي قوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إنه لا يقتضي العموم وارتفاع الحكم، لان بمحل الكلام يتبين أنه ليس المراد أصل العمل فإن ذلك يتحقق بغير النية ومع الخطأ والنسيان والاكراه، فإما أن يكون المراد الحكم أو الاثم، ولا يجوز أن يقال كل واحد منهما مراد لانهما يبتنيان على معنيين متغايرين فإن الثواب على العمل الذي هو عبادة والاثم بالعمل الذي هو محرم يبتني على العزيمة والقصد، والجواز والفساد الذي هو حكم يبتني على الاداء بالاركان والشرائط، ألا ترى أن من توضأ بالماء النجس وهو لا يعلم به فصلى لم تجز صلاته مطلقا حتى لو علم لزمه الاعادة ومع ذلك إذا لم يعلم ولم يكن منه التقصير كان مطيعا باعتبار قصده وعزيمته فيكون هذا بمنزلة المشترك الذي لا عموم له لتغاير المعنى فيما يحتمله فلا يجوز الاحتجاج به في حكم
الجواز والفساد إلا بدليل يقترن به فيصير كالمؤول حينئذ، فأما ما يعترض من الدليل
الموجب للنسخ أو التخصيص فليس من هذا الباب في شئ، وإنما هذا الباب لمعرفة الوجوه فيما يقترن بالكلام فيصير حقيقة ودليل النسخ والتخصيص كلام معارض إلا أن النسخ معارض صورة وحقيقة والتخصيص معارض صورة، وبيان معنى حتى لا يكون إلا بالمقارن ولكن ذلك المقارن إنما يتبين بما هو نسخ مبتدأ صيغة، فعرفنا أنه ليس من هذا الباب في شئ.
قال رضي الله عنه: والعراقيون من مشايخنا رحمهم الله يزعمون أنه لا عموم للنصوص الموجبة لتحريم الاعيان نحو قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) وقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) وقوله عليه السلام: حرمت الخمر لعينها وقالوا امتنع ثبوت حكم العموم في هذه الصورة معنى لدلالة محل الكلام وهو أن الحل والحرمة لا تكون وصفا للمحل وإنما تكون وصفا لافعالنا في المحل حقيقة فإنما يصير المحل موصوفا به مجازا وهذا غلط فاحش، فإن الحرمة بهذه النصوص ثابتة للاعيان الموصوفة بها حقيقة، لان إضافة الحرمة إلى العين تنصيص على لزومه وتحققه فيه، فلو جعلنا الحرمة صفة للفعل لم تكن العين حراما، ألا ترى أن شرب عصير الغير وأكل مال الغير فعل حرام ولم يكن ذلك دليلا على حرمة العين ولزوم هذا الوصف للعين، ولكن عمل هذه النصوص في إخراج هذه المحال من أن تكون قابلة للفعل الحلال وإثبات صفة الحرمة لازمة لاعيانها فيكون ذلك بمنزلة النسخ الذي هو رفع حكم وإثبات حكم آخر مكانه، فبهذا الطريق تقوم العين مقام الفعل في إثبات صفة الحرمة والحل له حقيقة، وهذا إذا تأملت في غاية التحقيق، فمع إمكان العمل بهذه الصيغة جعل هذه الحرمات مجازا باعتبار أنها صفة للفعل لا للمحل يكون خط فاحشا.
فصل: في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام قد بينا أن الكلام ضربان: حقيقة ومجاز، وأنه لا يحمل على المجاز إلا عند تعذر حمله على الحقيقة، فتمس الحاجة إلى معرفة الحقيقة والمجاز، والطريق في ذلك هو النظر في السبب الداعي إلى تعريف ذلك الاسم في الاسماء الموضوعة لا لمعنى، وإلى تعريف المعنى في المعنويات، فما كان أقرب في ذلك فهو أحق، وما كان أكثر إفادة فهو أولى بأن يجعل حقيقة، وذلك يكون بطريقين: التأمل في محل الكلام، والتأمل في صيغة الكلام.
أما بيان التأمل في المحل في اختلاف العلماء في موجب العام فعند بعضهم موجبه عند الاطلاق أخص الخصوص، وعندنا موجبه العموم، وما قلناه أحق لانه إذا حمل على أخص الخصوص يبقى بعض ما تناوله مطلق الكلام غير مراد به، والمراد بالكلام تعريف ما وضع الاسم له، فإذا كان صيغة العام موضوعا لمعنى العموم كان حمله عليه عند الاطلاق أحق، ولان الخاص اسم آخر وهو ما وضع له صيغة الخاص فلو جعلنا صيغة العام تناولا للخاص أيضا فقط كان ذلك تكرارا محصنا، وإذا كان المقصود بوضع الاسماء في الاصل إعلام المراد فحمل لفظين على شئ واحد يكون تكرارا وإخراجا لاحد اللفظين من أن يكون مفيدا.
فإن قيل: فائدته التأكيد وتوسيع الكلام، قلنا: نعم ولكن هذا في الفائدة دون الفائدة المطلوبة بأصل الوضع، والاطلاق يوجب الكمال فإذا حمل كل واحد من اللفظين على فائدة جديدة باعتبار أصل الوضع كان ذلك أولى من أن يحمل على التكرار لتوسعة الكلام، فهذان الدليلان من محل الكلام قبل التأمل في صيغة اللفظ ولهذا حملنا قوله تعالى: (أو لامستم النساء) على المجامعة دون المس باليد لانه إذا حمل على المس باليد كان تكرارا لنوع حدث واحد، وإذا حمل على المجامعة كان
بيانا لنوعي الحدث وأمرا بالتيمم لهما فيكون أكثر فائدة مع أنه معطوف على
ما سبق والسابق ذكر نوعي الحدث، فإن قوله: (إذا قمتم إلى الصلاة) : أي وأنتم محدثون، ثم قال تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) ثم قال تعالى: (وإن كنتم مرضى) إلى قوله: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) فبدلالة محل الكلام يتبين أن المراد الجماع دون المس باليد.
وبيان الدلالة من صيغة الكلام في قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) قال علماؤنا رحمهم الله: اللغو ما يكون خاليا عن فائدة اليمين شرعا ووضعا، فإن فائدة اليمين إظهار الصدق من الخبر فإذا أضيف إلى خبر ليس فيه احتمال الصدق كان خاليا عن فائدة اليمين فكان لغوا.
وقال الشافعي رحمه الله: اللغو ما يجري على اللسان من غير قصد، ولا خلاف في جواز إطلاق اللفظ على كل واحد منهما.
ولكن ما قلناه أحق لان ما يجري على لسانه من غير قصد له اسم آخر موضوع وهو الخطأ الذي هو ضد العمد أو السهو الذي هو ضد التحفظ، فأما ما يكون خاليا عن الفائدة لمعنى في نفسه لا بحال المتكلم فليس له اسم موضوع سوى أنه لغو فحمله عليه أولى، ألا ترى إلى قوله: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) يعني الكلام الفاحش الذي هو خال عن فائدة الكلام بطريق الحكمة دون ما يجري من غير قصد فإن ذلك لا عتب فيه، وقال تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما) وقال تعالى: (والغوا فيه لعلكم تغلبون) ومعلوم أن مراد المشركين التعنت أي إن لم تقدروا على المغالبة بالحجة فاشتغلوا بما هو خال عن الفائدة من الكلام ليحصل مقصودكم بطريق المغالبة دون المحاجة ولم يكن مقصودهم التكلم بغير قصد، وقال تعالى: (وإذا مروا باللغو مروا كراما) : أي صبروا عن الجواب وذلك في الكلام الخالي عن الفائدة دون ما يجري من غير قصد، ولان فساد ما يجري
من غير قصد باعتبار معنى في المحل وهو القلب الذي هو السبب الباعث على التكلم، وفساد مالا فائدة فيه باعتبار معنى في نفس الكلام فكان هو أقرب إلى الحقيقة فيحمل اللفظ عليه عند الاطلاق.
وكذا اختلفوا في العقد فقال الخصم: العقد عبارة
عن القصد فإن العزيمة سميت عقيدة.
وقلنا: العقد اسم لربط كلام بكلام نحو ربط لفظ اليمين بالخبر الذي فيه رجاء الصدق لايجاب حكم (بكلام) وهو الصدق منه، وكذلك ربط البيع بالشراء لايجاب حكمه وهو الملك فكان ما قلناه أقرب إلى الحقيقة، لان الكلمة باعتبار الوضع من عقد الحبل وهو شد بعضه ببعض وضده الحل، منه تقول العرب: يا عاقدا ذكر حلا، وقال القائل: ولقلب المحب حل وعقد ثم يستعار (لربط الايجاب بالقبول على وجه ينعقد أحدهما بالآخر حكما فيسمى عقدا ثم يستعار) لما يكون سببا لهذا الربط وهو عزيمة القلب فكان ذلك دون العقد الذي هو ضد الحل فيما وضع الاسم له فحمله عليه يكون أحق.
ومن ذلك ما قلنا في قوله تعالى: (ثلاثة قروء) إنها الحيض دون الاطهار، لان اللفظ إما أن يكون مأخوذا من القرء الذي هو الاجتماع، قال تعالى: (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) وقال القائل: هجان اللون لم يقر أجنبيا وهذا المعنى في الحيض أحق، لان معنى الاجتماع في قطرات الدم على وجه لا بد منه ليكون حيضا فإنه ما لم تمتد رؤية الدم لا يكون حيضا وإن كان الدم يجتمع في حالة الطهر في رحمها فالاسم حقيقة للدم المجتمع، ثم زمانه يسمى به مجازا وإن كان مأخوذا من الوقت المعلوم كما قال القائل: إذا هبت لقارئها الرياح
وقال آخر: له قرء كقرء الحائض فذلك بزمان الحيض أليق، لانه هو الوقت المعلوم الذي يحتاج إلى إعلامه لمعرفة ما تعلق به من الاحكام، وإن كان مأخوذا من معنى الانتقال كما يقال: قرأ النجم إذا انتقل، فحقيقة الانتقال تكون بالحيض لا بالطهر، إذ الطهر أصل، فباعتبار صيغة اللفظ يتبين أن حمله على الحيض أحق،
وكذلك لفظ النكاح فإنما نحمله على الوطئ والخصم على العقد، وما قلناه أحق لان الاسم في أصل الوضع لمعنى الضم والالتزام يقول القائل أنكح الصبر أي التزمه وضمه إليك، ومعنى الضم في الوطئ يتحقق بما يحصل من معنى الاتحاد بين الواطئين عند ذلك الفعل ولهذا يسمى جماعا، ثم العقد يسمى نكاحا باعتبار أنه سبب يتوصل به إلى ذلك الضم، فبالتأمل في صيغة اللفظ يتبين أن الوطئ أحق به إلا في الموضع الذي يتعذر حمله عليه فحينئذ يحمل على ما هو مجاز عنه وهو العقد، وهذا هو الحكم في كل لفظ محتمل للحقيقة والمجاز أنه إذا تعذر حمله على الحقيقة يحمل على المجاز لتصحيح الكلام، وهذا التعذر إما لعدم الامكان أو لكونه مهجورا عرفا أو لكونه مهجورا شرعا، فالذي هو متعذر نحو ما إذا حلف أن لا يأكل من هذه النخلة أو من هذه الكرمة فإن يمينه تنصرف إلى الثمرة لان ما هو الحقيقة في كلامه متعذر، وأما المهجور عرفا فنحو ما إذا حلف أن لا يشرب من هذه البئر فإنه ينصرف يمينه إلى الشرب من ماء البئر لان الحقيقة وهو الكرع في البئر مهجورة، واختلف مشايخنا أنه إذا كرع هل يحنث أم لا ؟ فمنهم من يقول يحنث أيضا لان الحقيقة لا تتعطل وإن حمل اللفظ على المجاز، وسواء أخذ الماء في كوز وشربه أو كرع في البئر فقد شرب ماء البئر فيحنث، ومنهم من يقول لا يحنث، لانه لما صار المجاز مرادا سقط اعتبار الحقيقة على ما قال في الجامع: لو قال لاجنبية إن نكحتك فعبدي حر ينصرف يمينه إلى العقد دون الوطئ.
ولو قال لزوجته: إن نكحتك ينصرف إلى الوطئ
دون العقد حتى لو أبانها ثم تزوجها لم يحنث ما لم يطأها.
ولو قال للمطلقة الرجعية: إن راجعتك ينصرف إلى الرجعة دون ابتداء العقد، ولو قال للمبانة: إن راجعتك ينصرف إلى ابتداء العقد ولكن الاول أوجه لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز في كونه مرادا باللفظ بل باعتبار عموم المجاز وهو شرب ماء البئر بأي طريق شربه، وعلى هذا قلنا مطلق التوكيل بالخصومة ينصرف إلى الجواب وإن كان ذلك مجازا لان الحقيقة مهجورة شرعا، فإن المدعي إذا كان محقا فالمدعي عليه لا يملك الانكار شرعا ولا يجوز له التوكيل بذلك فيحمل اللفظ على المجاز عند الاطلاق، ثم يصح منه الانكار والاقرار باعتبار معنى عموم المجاز وهو أنه جواب للخصم.
ومن حلف أن لا يكلم هذا الصبي فكلمه بعدما صار شيخا يحنث باعتبار أن الحقيقة مهجورة
شرعا فإن الصبي سبب للترحم شرعا لا للهجران فيتعين المجاز لهذا.
وأمثلة هذا أكثر من أن تحصى، والله أعلم.
باب: بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه قال رضي الله عنه: اعلم بأن الكلام عند العرب اسم وفعل وحرف، وكما يتحقق معنى الحقيقة والمجاز في الاسماء والافعال فكذلك يتحقق في الحروف، فمنه ما يكون مستعملا في حقيقته، ومنه ما يكون مجازا عن غيره، وكثير من مسائل الفقه تترتب على ذلك فلا بد من بيان هذه الحروف وذكر الطريق في تخريج المسائل عليها.
فأولى ما يبدأ به من ذلك حروف العطف.
الاصل فيه الواو فلا خلاف أنه للعطف (ولكن عندنا هو للعطف) مطلقا فيكون موجبه الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر من غير أن يقتضي مقارنة أو ترتيبا، وهو قول أكثر أهل اللغة.
وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله: إنه موجب للترتيب، وقد ذكر ذلك الشافعي في أحكام القرآن، وكذلك
جعل الترتيب ركنا في الوضوء لان في الآية عطف اليد على الوجه بحرف الواو فيجب الترتيب بهذا النص، ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السعي بأيهما نبدأ قال: ابدؤوا بما بدأ الله تعالى يريد به قوله تعالى: (إن الصفا والمروة) ففي هذا تنصيص على أن موجب الواو الترتيب، وما وجب ترتيب السجود على الركوع إلا بقوله تعالى: (اركعوا واسجدوا) ولكنا نقول: هذا من باب اللسان، فطريق معرفته التأمل في كلام العرب وفي الاصول الموضوعة عند أهل اللغة، بمنزلة ما لو وقعت الحاجة إلى معرفة حكم الشرع يكون طريقه التأمل في النصوص من الكتاب والسنة والرجوع إلى أصول الشرع، وعند التأمل في كلام العرب وأصول اللغة يتبين أن الواو لا توجب الترتيب، فإن القائل يقول: جاءني زيد وعمرو يفهم من هذا الاخبار مجيئهما من غير
مقارنة ولا ترتيب حتى يكون صادقا في خبره، سواء جاءه عمرو أولا ثم زيد أو زيد ثم عمرو أو جاءا معا.
وكذلك وضعوا الواو للجمع مع النون يقولون: جاءني الزيدون أي زيد وزيد وزيد، والقائل يقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيفهم منه المنع من الجمع بينهما دون الترتيب على ما قال القائل: لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ولو وضع مكان الواو هنا الفاء لم يكن الكلام مستقيما، فالفاء توجب ترتيبا من حيث إنه للتعقيب مع الوصل، فلو كان موجب الواو الترتيب لم يختل الكلام بذكر الفاء مكانه، وكذلك يتبدل الحكم أيضا إذا ذكر الواو مكان الفاء، فإن من يقول لامرأته: إن دخلت الدار وأنت طالق تطلق في الحال، فلو كان موجب الواو الترتيب لكان هو بمنزلة الفاء فينبغي أن يتأخر الطلاق إلى وجود الشرط.
وأما من حيث الوضع لغة فلانهم وضعوا كل حرف ليكون دليلا على معنى مخصوص كما فعلوا
في الاسماء والافعال، فالاشتراك لا يكون إلا لغفلة من الواضع أو لعذر، وتكرار اللفظ لمعنى واحد يوجب إخلاءه عن الفائدة كما قررنا فلا يليق ذلك بالحكمة.
ثم إنهم وضعوا الفاء للوصل مع التعقيب، وثم للتعقيب مع التراخي، ومع للقران.
فلو قلنا بأن الواو توجب القران أو الترتيب كان تكرارا باعتبار أصل الوضع، ولو قلنا إنه يوجب العطف مطلقا لكان لفائدة جديدة باعتبار أصل الوضع، ثم يتنوع هذا العطف أنواعا لكل نوع منه حرف خاص.
ونظيره من الاسماء الانسان فإنه للآدمي مطلقا ثم يتنوع أنواعا لكل نوع منه اسم خاص بأصل الوضع والتمر كذلك.
وهو نظير ما قلنا في اسم الرقبة إنه للذات مطلقا من غير أن يكون دالا على معنى التقييد بوصف فكذلك الواو للعطف (مطلقا) باعتبار أصل الوضع، ولهذا قلنا: المنصوص عليه في آية الوضوء الغسل والمسح من غير ترتيب ولا قران، ثم كان الترتيب باعتبار فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك للاكمال فيتأدى الركن بما هو المنصوص وتتعلق صفة الكمال بمراعاة الترتيب فيه.
وكذلك في قوله
تعالى: (اركعوا واسجدوا) فإنا ما عرفنا الترتيب بهذا النص إذ النصوص فيه متعارضة، فإنه تعالى قال: (واسجدي واركعي مع الراكعين) ولكن مراعاة ذلك الترتيب بكون الركوع مقدمة السجود والقيام مقدمة الركوع على ما نبينه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وكذلك قوله تعالى: (إن الصفا والمروة) فإن مراعاة الترتيب بينهما ليس باعتبار هذا النص ففي النص بيان أنهما من شعائر الله ولا ترتيب في هذا وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدؤوا بما بدأ الله تعالى على وجه التقريب إلى الافهام لا لبيان أن الواو توجب الترتيب، فإن الذي يسبق إلى الافهام في مخاطبات العباد أن البدائية تدل على زيادة العناية فيظهر بها نوع قوة صالحة للترجيح، ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله فيمن أوصى بقرب لا تسع الثلث لها فإنه
يبدأ بما بدأ به الموصي إذا استوت في صفة اللزوم، لان البداية تدل على زيادة الاهتمام، وقد زعم بعض مشايخنا أن معنى الترتيب يترجح في العطف الثابت بحرف الواو في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله يترجح معنى القران، وخرجوا على هذا ما إذا قال لامرأته ولم يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت فإنها تطلق واحدة عند أبي حنيفة باعتبار أنه مترتب وقوع الثانية على الاولى وهي تبين في الاولى لا إلى عدة، وعندهما تقع الثلاث عليها باعتبار أنهن يقعن جملة عند الدخول معا، وهذا غلط فلا خلاف بين أصحابنا أن الواو للعطف مطلقا إلا أنهما يقولان موجبه الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر.
وقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق جملة تامة، وقوله وطالق جملة ناقصة لانه ليس فيها ذكر الشرط فباعتبار العطف يصير الخبر المذكور في الجملة التامة كالمعاد في الجملة الناقصة، فيتعلق كل تطليقة بالدخول بلا واسطة وعند الدخول ينزلن جملة كما لو كرر ذكر الشرط مع كل تطليقة، ألا ترى أنه إذا قال: جاءني زيد وعمرو كان المفهوم من هذا ما هو المفهوم من قوله: جاءني زيد جاءني عمرو.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الواو للعطف وإنما يتعلق الطلاق بالشرط كما علقه وهو علق الثانية بالشرط بواسطة الاولى، فإن من ضرورة العطف هذه الواسطة، فالاولى تتعلق بالشرط بلا واسطة والثاني بواسطة الاولى، بمنزلة القنديل المعلق بالحبل بواسطة الحلق، ثم عند وجود الشرط ينزل ما تعلق فينزل كما تعلق، ولكنهما
يقولان هذا أن لو كان المتعلق بالشرط طلاقا وليس كذلك بل المتعلق ما سيصير طلاقا عند وجود الشرط إذا وصل إلى المحل، فإنه لا يكون طلاقا بدون المحل.
ثم هذه الواسطة في الذكر فتتفرق به أزمنة التعليق وذلك لا يوجب التفرق في الوقوع كما لو كرر الشرط في كل تطليقة وبينهما أيام.
وما قاله أبو حنيفة رحمه الله أقرب إلى
مراعاة حقيقة اللفظ ومعلوم أنه عند وجود الشرط ذلك الملفوظ به يصير طلاقا، فإذا كان من ضرورة العطف إثبات هذه الواسطة ذكرا فإن عند وجود الشرط يصير ذلك طلاقا واقعا ومن ضرورة تفرق الوقوع أن لا يقع إلا واحدة فإن هذا تبين به لا إلى عدة كما لو نجز فقال أنت طالق وطالق وطالق.
وقال مالك في التنجيز أيضا تطلق ثلاثا لان الواو توجب المقارنة، ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار تطلق ثلاثا عند الدخول جملة.
وهذا غلط فإن للقران حرفا موضوعا وهو مع فلو حملنا الواو عليه كان تكرارا، وإذا أخر الشرط في التعليق إنما تطلق ثلاثا لا بهذا المعنى بل لان الاصل في الكلام المعطوف أنه متى كان في آخره ما يغير موجب أوله توقف أوله على آخره، ولهذا لو ذكر استثناء في آخر الكلام بطل الكل به فكذلك إذا ذكر شرطا، لان بالتعليق بالشرط تبين أن المذكور أولا ليس بطلاق، وإذا توقف أوله على آخره تعلق الكل بالشرط جملة، وإذا كان الشرط سابقا فليس في آخر الكلام ما يغير موجب أوله.
وكذلك في التنجيز فإن الاول طلاق سواء ذكر الثاني أو لم يذكر، فإذا لم يتوقف أوله على آخره بانت بالاولى فلغت الثانية والثالثة لانعدام محل الوقوع لا لفساد في التكلم أو العطف.
ثم على قول أبي يوسف رحمه الله تقع الاولى قبل أن يفرغ من التكلم بالثانية، وعند محمد عند الفراغ من التكلم بالثانية تقع الاولى لجواز أن يلحق بكلامه شرطا أو استثناء مغيرا.
وما قاله أبو يوسف أحق فإنه ما لم يقع الطلاق لا يفوت المحل، فلو كان وقوع الاولى بعد الفراغ من التكلم بالثانية لوقعا جميعا لوجود المحل مع صحة التكلم بالثانية.
وعلى هذا قال زفر رحمه الله: لو قال لغير
المدخول بها: أنت طالق واحدة وعشرين تطلق واحدة، لان الواو للعطف فتبين بالواحدة قبل ذكر العشرين.
ولكنا نقول: تلك كلمة واحدة حكما لانه لا يمكنه
أن يعبر عن هذا العدد بعبارة أوجز من هذا، وعطف البعض على البعض يتحقق في كلمتين لا في كلمة واحدة فإنما يقع هنا عند تمام الكلام فتطلق ثلاثا، كما لو قال واحدة ونصفا تطلق اثنتين، لانه ليس لما صرح به عبارة أوجز من ذلك فكانت كلمة واحدة حكما، وعند زفر تطلق واحدة.
وعلى هذا الاصل ما قال في الجامع: لو تزوج أمتين بغير إذن مولاهما ثم أعتقهما المولى معا جاز نكاحهما.
ولو قال: أعتقت هذه وهذه جاز نكاح الاولى وبطل نكاح الثانية لانه ليس في آخر كلامه ما يغير موجب أوله فنكاح الاولى صحيح أعتق الثانية أو لم يعتق، وبنفوذ العتق في الاولى تنعدم محلية النكاح في حق الثانية لان الامة ليست من المحللات مضمومة إلى الحرة.
ومثله لو زوج منه رضيعتين في عقدين بغير رضاه فأرضعتهما امرأة ثم أجاز الزوج نكاحهما معا بطل نكاحهما.
ولو قال: أجزت نكاح هذه وهذه بطل نكاحهما أيضا لان في آخر كلامه ما يغير موجب أوله فإن بآخر الكلام يثبت الجمع بين الاختين نكاحا وذلك مبطل لنكاحهما فيتوقف أول الكلام على آخره.
وكان الفراء يقول الواو للجمع والمجموع بحرف الواو كالمجموع بكناية الجمع، وعندنا الواو للعطف والاشتراك على أن يصير كل واحد من المذكورين كأنه مذكور وحده لا على وجه الجمع بينهما ذكرا.
وبيان هذا فيما إذا كان لرجل ثلاثة أعبد فقال: هذا حر أو هذا وهذا فإنه يخير في الاولين ويعتق الثالث عينا، كأنه قال هذا حر أو هذا حر، وعند الفراء يخير فإن شاء أوقع العتق على (الاول وإن شاء على) الثاني والثالث، لانه جمع بينهما بحرف الواو فكأنه جمع بكناية الجمع فقال هذا حر وهذان.
واستدل بما قال في الجامع: رجل مات وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وترك ابنا فقال الابن أعتق والدي هذا في مرضه وهذا وهذا، يعتق من كل واحد منهم ثلثه بمنزلة ما لو قال أعتقهم.
ولو قال: أعتق هذا وسكت ثم قال وهذا
ثم سكت ثم قال هذا يعتق الاول كله ومن الثاني نصفه ومن الثالث ثلثه.
ولكنا نقول: لا وجه لتصحيح كلامه على ما قاله الفراء لان خبر المثنى غير خبر الواحد يقال للواحد حر وللاثنين حران والمذكور في كلامه من الخبر قوله حر فإذا لم يجعل كان كل واحد من الآخرين منفردا بالذكر لا يصلح أن يكون الخبر المذكور خبرا لهما والعطف للاشتراك في الخبر لا لاثبات خبر آخر، وإذا جعلنا الثالث كالمنفرد بالذكر صار كأنه قال أحد هذين حر وهذا فيكون فيه ضم الثالث إلى المعتق من الاولين لا إلى غير المعتق فلهذا عتق الثالث.
ومسألة الجامع إنما تخرج على الاصل الذي بينا، فإن في آخر كلامه ما يغير موجب أوله لان موجب أول الكلام عتق الاول مجانا بغير سعاية ويتغير ذلك بآخر كلامه عند أبي حنيفة رحمه الله لان المستسعي بمنزلة المكاتب (عنده) فيتغير حكم أصل العتق، وعندهما يتغير حكم البراءة عن السعاية، فلهذا توقف أوله على آخره.
واختلفوا في عطف الجملة التامة على الجملة التامة بحرف الواو نحو ما إذا قال: زينب طالق ثلاثا وعمرة طالق فإنما تطلق عمرة واحدة وكل واحد من الكلامين جملة تامة لانه ابتداء وخبر فالواو بينهما عند بعض مشايخنا لمعنى الابتداء يحسن نظم الكلام كما في قوله تعالى: (والراسخون في العلم) وقوله تعالى: (ويمحو الله الباطل) وقوله تعالى في حكم القذف: (وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) فإنه ابتداء عندنا.
قال رضي الله عنه: والاصح أن هذا الواو للعطف أيضا عندي إلا أن الاشتراك في الخبر ليس من حكم بمجرد العطف بل باعتبار حاجة المعطوف إليه إذا لم يذكر خبرا ولا حاجة إذا ذكر له خبرا، ولهذا عند الحاجة جعلنا خبر المعطوف عين ما هو خبر المعطوف عليه إذا أمكن لا غيره، لان الحاجة ترتفع بعين ذلك، حتى إذا قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار الاخرى فإنما يتعلق بدخول الدار الثانية تلك التطليقة لا غيرها، حتى لو دخلت الدارين لم تطلق إلا واحدة،
فأما إذا تعذر ذلك بأن يقول: فلانة طالق وفلانة فإنه يقع على الثانية غير ما وقع على الاولى لان الاشتراك بينهما في تطليقة واحدة لا يتحقق، بمنزلة قوله: جاءني زيد
وعمرو فإنه إخبار عن مجئ كل واحد منهما بفعل على حدة لان مجيئهما بفعل واحد لا يتحقق.
وعلى هذا الاصل الذي بينا أن الواو لا توجب الترتيب يخرج ما قال في كتاب الصلاة: وينوي بالتسليمة الاولى من عن يمينه من الحفظة والرجال والنساء، فإن مراده العطف لا الترتيب.
وكذلك مراده مما قال في الجامع الصغير: من الرجال والنساء والحفظة فإن الترتيب (في النية) لا يتحقق، فعرفنا أن المراد يجمعهم في نيته.
وقد تكون الواو بمعنى الحال لمعنى الجمع أيضا فإن الحال يجامع ذا الحال، ومنه قوله تعالى: (حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها) : أي جاؤوها حال ما تكون أبوابها مفتوحة.
وعلى هذا قال في المأذون إذا قال لعبده: أد إلي ألفا وأنت حر إنه لا يعتق ما لم يؤد لان الواو بمعنى الحال فإنما جعله حرا عند الاداء وقال في السير: إذا قال افتحوا الباب وأنتم آمنون لا يأمنون ما لم يفتحوا لانه آمنهم حال فتح الباب، وإذا قال لامرأته: أنت طالق وأنت مريضة تطلق في الحال لان الواو للعطف في الاصل فلا يكون شرطا، فإن قال عنيت إذا مرضت يدين فيما بينه وبين الله تعالى لانه عني بالواو الحال وذلك محتمل فكأنه قال في حال مرضها.
وكذلك لو قال: أنت طالق وأنت تصلين أو وأنت مصلية.
وقال في المضاربة: إذا قال خذ هذه الالف واعمل بها مضاربة في البز فإنه لا يتقيد بصرفه في البز وله أن يتجر فيها ما بدا له من وجوه التجارات لان الواو للعطف فالاطلاق الثابت بأول الكلام لا يتغير بهذا العطف.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا قالت المرأة لزوجها طلقني ولك ألف درهم فطلقها تجب الالف عليها، وكذلك لو قال الزوج أنت طالق وعليك ألف درهم فقبلت تجب الالف.
وفيه طريقان لهما: أحدهما أنه استعمل الواو بمعنى الباء مجازا فإن ذلك
معروف في القسم إذ لا فرق بين قوله والله وبين قوله بالله، وإنما حملنا على هذا المجاز بدلالة المعاوضة فإن الخلع عقد معاوضة فكان هذا بمنزلة ما لو قال احمل هذا المتاع إلى منزلي ولك درهم، والثاني أن هذا الواو للحال فكأنها قالت طلقني في حال ما يكون لك علي ألف درهم، وإنما حملنا على هذا لدلالة المعاوضة كما في قوله أد إلي ألفا وأنت
طالق، بخلاف المضاربة فلا معنى لحرف الباء هناك حتى يجعل الواو عبارة عنه، ولا يمكن حمله على معنى الحال لانعدام دلالة المعاوضة فيه، وأبو حنيفة رحمه الله يقول تطلق ولا شئ عليها لان الواو للعطف حقيقة وباعتبار هذه الحقيقة لا يمكن أن يجعل الالف بدلا عن الطلاق فلو جعل بدلا إنما يجعل بدلالة المعاوضة وذلك في الطلاق زائد فإن الطلاق في الغالب يكون بغير عوض، ألا ترى أن بذكر العوض يصير كلام الزوج بمعنى اليمين حتى لا يمكنه أن يرجع عنه قبل قبولها ولا يجوز ترك الحقيقة باعتبار دليل زائد على ما وضع له في الاصل، بخلاف الاجارة فإنه عقد مشروع بالبدل لا يصح بدونه فأمكن حمل اللفظ على المجاز باعتبار معنى المعاوضة فيه لانه أصل، وإنما يجعل الواو للحال إذا كان بصيغة تحتمل ذلك كما في قوله أد وأنت حر انزل وأنت آمن فإن صيغة كلامه للحال لانه خاطبه بالاول والآخر بصيغة واحدة ويتحقق عتقه في حالة الاداء ويتحقق أمانه في حالة النزول، لان المقصود أن يعلم بمحاسن الشريعة فعسى يؤمن وذلك حالة النزول.
فأما قوله خذ هذه الالف واعمل بها في البز فليس في هذه الصيغة احتمال الحال لان البز لا يكون حالا لعمله، وقوله أنت طالق وأنت مريضة للعطف حقيقة ولكن فيه احتمال الحال إذ الطلاق يتحقق في حال المرض، فلاعتبار الظاهر لا يدين في القضاء، ولاحتمال كونه محتملا تعمل نيته.
فصل
وأما الفاء فهو للعطف، وموجبه التعقيب بصفة الوصل، فيثبت به ترتيب وإن لطف ذلك، لما بينا أن كل حرف يختص بمعنى في أصل الوضع، إذ لو لم يجعل كذلك خرج من أن يكون مفيدا، فالمعنى الذي اختص به الفاء ما بينا، ألا ترى أن أهل اللسان وصلوا حرف الفاء بالجزاء وسموه حرف الجزاء لان الجزاء يتصل بالشرط على أن يتعقب نزوله وجود الشرط بلا فصل، وكذلك يستعمل حرف الفاء لعطف الحكم
على العلة، يقال: جاء الشتاء فتأهب، ويقال: ضرب فأوجع أي بذلك الضرب، وأطعم فأشبع، أي بذلك الطعام، وعلى هذا قوله عليه السلام: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه: أي بذلك الشراء، ولهذا جعلنا الشراء إعتاقا في القريب بواسطة الملك.
ويقول: خذ من مالي ألف درهم فصاعدا، أي فما يزداد عليه فصاعدا وارتفاعا.
وعلى هذا الاصل قال علماؤنا رحمهم الله فيمن قال لغيره: بعت منك هذا العبد بألف درهم وقال المشتري فهو حر فإنه يعتق ويجعل قابلا ثم معتقا، بخلاف ما لو قال هو حر أو وهو حر فإنه يكون ردا للايجاب لا قبولا فلا يعتق.
ولو قال لخياط: انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصا فقال نعم قال فاقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه قميصا كان الخياط ضامنا لان الفاء للوصل والتعقيب فكأنه قال فإن كفاني قميصا فاقطعه، بخلاف ما لو قال اقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه قميصا فإنه لا يكون ضامنا لوجود الاذن مطلقا.
وقد قال بعض مشايخنا: إذا قال لغير المدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق فدخلت إنها تطلق واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله باعتبار أن الفاء يجعل مستعارا عن الواو مجازا لقرب أحدهما من الآخر.
قال رضي الله عنه: والاصح عندي أن هاهنا تطلق واحدة عندهم جميعا.
لان الفاء للتعقيب فيثبت به ترتيب بين الثانية والاولى في الوقوع ومع الترتيب لا يمكن إيقاع الثانية لانها تبين بالاولى ومع إمكان اعتبار الحقيقة لا معنى للمصير إلى المجاز.
والدليل
على أن الصحيح هذا ما قال في الجامع: إن دخلت هذه الدار فدخلت هذه الدار الاخرى فأنت طالق فإن الشرط أن تدخل الثانية بعد دخول الدار الاولى حتى لو دخلت في الثانية قبل الاولى ثم دخلت في الاولى لم تطلق، بخلاف ما لو قال: ودخلت هذه الدار.
وقد توصل الفاء بما هو علة إذا كان محتمل الامتداد، يقول الرجل لغيره: أبشر فقد أتاك الغوث وهذا على سبيل بيان العلة للخطاب بالبشارة ولكن لما كان ذلك ممتدا صح ذكر حرف الفاء مقرونا به، وعلى هذا الاصل لو قال لعبده: أد إلي ألفا فأنت حر فإنه يعتق وإن لم يؤد، لانه لبيان العلة، أي لانك قد صرت حرا وصفة الحرية تمتد.
وكذلك لو قال لحربي: انزل فأنت آمن كان آمنا
نزل أو لم ينزل، لان معنى كلامه انزل لانك آمن والامان ممتد، فأما ما قال علماؤنا رحمهم الله فيمن يقول: لفلان علي درهم فدرهم إنه يلزمه درهمان فذلك لتحقيق معنى العطف إذ المعطوف غير المعطوف عليه واعتبار معنى الوصل والترتيب في الوجوب لا في الواجب، أو لما تعذر اعتبار حقيقة معنى حرف الفاء جعل عبارة عن الواو مجازا فكأنه قال درهم ودرهم.
والشافعي يقول يلزمه درهم واحد، لان ما هو موجب حرف الفاء لا يتحقق هاهنا فيكون صلة للتأكيد كأنه قال درهم فهو درهم.
ولكن ما قلناه أحق لانه يضمر ليسقط به اعتبار حرف الفاء والاضمار لتصحيح ما وقع التنصيص عليه لا لالغائه، ثم معنى العطف محكم في هذا الحرف فلا بد من اعتباره بحسب الامكان، والمعطوف غير المعطوف عليه فيلزمه درهمان لهذا.
فصل وأما حرف ثم فهو للعطف على وجه التعقيب مع التراخي، هو المعنى الذي اختص به هذا الحرف بأصل الوضع.
يقول الرجل (جاءني زيد ثم عمرو فإنما يفهم منه ما يفهم من قوله) جاءني زيد وبعده عمرو، إلا أن عند أبي حنيفة رحمه الله
صفة هذا التراخي أن يكون بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف قولا بعد الاول لاتمام القول بالتراخي، وعندهما التراخي بهذا الحرف في الحكم مع الوصل في التكلم لمراعاة معنى العطف فيه.
وبيان هذا فيما إذا قال لغير المدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، عند أبي حنيفة رحمه الله تتعلق الاولى بالدخول وتقع الثانية في الحال وتلغو الثالثة، بمنزلة قوله أنت طالق طالق طالق من غير حرف العطف حتى ينقطع بعض الكلام عن البعض، وعندهما يتعلق الكل بالدخول ثم عند الدخول يظهر الترتيب في الوقوع فلا تقع إلا واحدة لاعتبار التراخي بحرف ثم.
ولو أخر الشرط ذكرا فعند أبي حنيفة رحمه الله تطلق واحدة في الحال ويلغو ما سواها، وعندهما لا تطلق ما لم تدخل الدار فإذا دخلت طلقت واحدة ولو كانت مدخولا بها، فإن أخر الشرط فعند أبي حنيفة رحمه الله تطلق اثنتين في الحال وتتعلق
الثالثة بالدخول، وعندهما ما لم تدخل لا يقع شئ فإذا دخلت طلقت ثلاثا.
ولو قدم الشرط فعند أبي حنيفة رحمه الله تقع الثانية والثالثة في الحال وتتعلق الاولى بالدخول، وعندهما لا يقع شئ ما لم تدخل فإذا دخلت طلقت ثلاثا، هكذا ذكر مفسرا في النوادر.
وقد يستعمل حرف ثم بمعنى الواو مجازا، قال الله تعالى: (ثم كان من الذين آمنوا) وقال تعالى: (ثم الله شهيد على ما يفعلون) وعلى هذا قلنا في قوله عليه السلام: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر يمينه إن حرف ثم في هذه الرواية محمول على الحقيقة، وفي الرواية التي قال فليكفر يمينه ثم ليأت بالذي هو خير حرف ثم بمعنى الواو مجازا لان صيغة الامر للايجاب وإنما التكفير بعد الحنث لا قبله فحملنا هذا الحرف على المجاز لمراعاة حقيقة الصيغة فيما هو المقصود، إذ لو حملنا حرف ثم على الحقيقة كان الامر بالتكفير
محمولا على المجاز فإنه لا يجب تقديم التكفير على الحنث بالاتفاق، فكان الاولى على هذا أن يجعل حرف ثم بمعنى حرف الفاء فإنه أقرب إليه من حرف الواو، وإنما لم نفعل ذلك لان حرف الفاء يوجب ترتيبا أيضا والحنث غير مرتب على التكفير بوجه فلهذا جعلناه بمعنى الواو.
فصل وأما حرف بل هو لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الاول وإظهار أن الاول كان غلطا، فإن الرجل يقول جاءني زيد بل عمرو أو لا بل عمرو فإنما يفهم منه الاخبار بمجئ عمرو خاصة، وهو معنى قوله تعالى: (بل كنتم مجرمين) .
(بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله) وعلى هذا قال زفر رحمه الله إن من قال لفلان علي ألف درهم بل ألفان يلزمه ثلاثة آلاف، لان بل لتدارك الغلط فيكون إقرارا بألفين ورجوعا عن الالف وبيان أنه كان غلطا ولكن الاقرار صحيح والرجوع
باطل، كما لو قال لامرأته أنت طالق واحدة بل اثنتين تطلق ثلاثا، ولكنا نقول يلزمه ألفان لانه ما كان مقصوده تدارك الغلط بنفي ما أقر به أولا بل تدارك الغلط بإثبات الزيادة التي نفاها في الكلام الاول بطريق الاقتضاء، فكأنه قال بل مع تلك الالف ألف أخرى فهما ألفان علي، ألا ترى أن الرجل يقول أتى علي خمسون سنة بل ستون فإنه يفهم هذا من كلامه بل ستون لعشرة زائدة على الخمسين التي أخبرت بها أولا، ولكن هذا يتحقق في الاخبارات لانها تحتمل الغلط ولا يتحقق في الانشاءات فلهذا جعلناه موقعا اثنتين راجعا عن الاولى ورجوعه لا يصح فتطلق ثلاثا، حتى لو قال كنت طلقتك أمس واحدة لا بل اثنتين تطلق اثنتين لان الغلط في الاخبار يتمكن، ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة لا بل اثنتين تطلق واحدة لانه بقوله بل اثنتين أولا بل اثنتين يروم الرجوع عن الاولى وذلك باطل
وبعدما بانت بالاولى لم يبق المحل ليصح إيقاع الثنتين عليها، ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة لا بل اثنتين فدخلت تطلق ثلاثا بالاتفاق لان مع تعلق الاولى بالشرط بقي المحل على حاله وهو بهذا الحرف تبين أنه تعلق الثنتين بالشرط ابتداء لا بواسطة الاولى، لانه راجع عن الاولى فكأنه أعاد ذكر الشرط وصار كلامه في حكم يمينين فعند وجود الشرط تقع الثلاث جملة لتعلق الكل بالشرط بلا واسطة، بخلاف ما قاله أبو حنيفة رحمه الله في حرف الواو فإنه للعطف فيكون هو مقررا للاولى ومعلقا الثانية بالشرط بواسطة الاولى، فعند وجود الشرط يقعن متفرقا أيضا فتبين بالاولى قبل وقوع الثانية والثالثة، والله أعلم.
فصل وأما لكن فهو كلمة موضوعة للاستدراك بعد النفي، تقول ما رأيت زيدا لكن عمرا، فالمعنى الذي تختص به هذه الكلمة باعتبار أصل الوضع إثبات ما بعدها فأما نفي ما قبلها فثابت بدليله بخلاف بل، قال تعالى: (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) ثم العطف بها إنما يكون عند اتساق الكلام فإن وجد ذلك كان لتعليق النفي بالاثبات الذي بعدها وإلا كانت للاستئناف.
وبيان هذا في مسائل مذكورة في الجامع: منها إذا قال رجل هذا العبد في يدي لفلان
فقال المقر له ما كان لي قط ولكنه لفلان، فإن وصل كلامه فهو للمقر له الثاني، وإن فصل فهو للمقر، لان قوله ما كان لي قط تصريح بنفي ملكه فيه، فإذا وصل به قوله لكن لفلان كان بيانا أنه نفي ملكه إلى الثاني بإثبات الملك له بقوله لكن، فإن قطع كلامه كان محمولا على نفي ملكه أصلا كما هو الظاهر وهو رد للاقرار، ثم قوله ولكنه لفلان شهادة بالملك للثاني على المقر وبشهادة الفرد لا يثبت الملك.
ولو أن المقضي له بالعبد بالبينة قال ما كان لي قط ولكنه لفلان فقال المقر له
قد كان له فباعه أو وهبه مني بعد القضاء له فإنه يكون للثاني، لانه حين وصل الكلام فقد تبين أنه نفي ملكه بإثباته للثاني وذلك يحتمل الانشاء بسبب كان بعد القضاء فيحمل على ذلك في حق المقر له إلا أن المقر يصير ضامنا قيمته للمقضي عليه لان ظاهر كلامه تكذيب لشهوده وإقرار بأن القضاء باطل وهذا حجة عليه، ولكن إنما يقرر هذا الحكم بعد ما تحول الملك إلى المقر له فيضمن قيمته للمقضي عليه.
ولو أن أمة زوجت نفسها من رجل بمائة درهم بغير إذن مولاها فقال المولى لا أجيزه لكن أجيزه بمائة وخمسين، أو قال لكن أجيزه إن زدتني خمسين فالعقد باطل لان الكلام غير متسق، فإن نفي الاجازة وإثباتها بعينها لا يتحقق فيه معنى العطف فيرتد العقد بقوله لا أجيزه ويكون قوله لكن أجيزه ابتداء بعد الانفساخ.
ولو قال لفلان علي ألف درهم قرض فقال فلان لا ولكنه غصب فإنه يلزمه المال لان الكلام متسق فيتبين بآخره أنه نفي السبب لا أصل المال وأنه قد صدقه في الاقرار بأصل المال ولا تفاوت في الحكم بين السببين، والاسباب مطلوبة للاحكام فعند انعدام التفاوت يتم تصديقه له فيما أقر به فيلزمه المال، وعلى هذا لو قال لك علي ألف درهم ثمن هذه الجارية التي اشتريتها منك فقال الجارية جاريتك ما بعتها منك ولكن لي عليك ألف درهم يلزمه المال، لان الكلام متسق وفي آخره بيان أنه مصدق له في أصل المال مكذب في السبب ولا تفاوت عند سلامة الجارية للمقر فيلزمه المال.
فصل وأما أو فهي كلمة تدخل بين اسمين أو فعلين، وموجبها باعتبار أصل الوضع يتناول أحد المذكورين.
بيانه في قوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) فإن الواجب في الكفارة أحد الاشياء المذكورة مع
إباحة التكفير بكل نوع منها على الانفراد، ولهذا لو كفر بالانواع كلها كان مؤديا للواجب بأحد الانواع في الصحيح من المذهب، بخلاف ما يقوله بعض الناس وقد بينا هذه.
وكذلك في قوله تعالى في كفارة الحلق: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) وفي جزاء الصيد: (هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) وقد ظن بعض مشايخنا أنها في أصل الوضع للتشكيك فإن الرجل إذا قال رأيت زيدا وعمرا يكون مخبرا برؤية كل واحد منهما عينا، ولو قال بل عمرا يكون مخبرا برؤية عمرو عينا.
ولو قال أو عمرا يكون مخبرا برؤية أحدهما غير عين على أنه شاك في كل واحد منهما يجوز أن يكون قد رآه ويجوز أن يكون لم يره إلا أن في الابتداءات والامر والنهي يتعذر حمله على التشكيك فإن ذلك لا يكون إلا عند التباس العلم بالشئ فيحمل على التخيير، وقرر هذا الكلام في تصنيفه.
قال رضي الله عنه: وعندي أن هذا غير صحيح لان الشك ليس بأمر مقصود حتى يوضع له كلمة في أصل الوضع، ولكن هذه الكلمة لبيان أن المتناول أحد المذكورين كما ذكرنا إلا أن في الاخبار يفضي إلى الشك باعتبار محل الكلام لا باعتبار هذه الكلمة كما في قوله رأيت زيدا أو عمرا، فأما في الانشاءات لما تبدل المحل وانعدم المعنى الذي لاجله كان معنى الشك فالثابت بهذه الكلمة التخيير باعتبار أصل الوضع وهو أنها تتناول أحد المذكورين على إثبات صفة الاباحة في كل واحد منهما، ولهذا قلنا لو قال هذا العبد حر أو هذا فهو وقوله أحدهما حر سواء يتناول الايجاب أحدهما ويتخير المولى في البيان على أن يكون بيانه من وجه كابتداء الايقاع حتى يشترط لصحة البيان صلاحية المحل للايقاع، ومن وجه هو تعيين للواقع، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لو جمع بين عبده ودابته وقال هذا حر أو هذا لغا كلامه،
بمنزلة ما لو قال أحدهما حر لان محل الايجاب أحدهما بغير عينه، وإذا لم يكن أحد
العبدين محلا صالحا للايجاب فغير المعين منهما لا يكون صالحا وبدون صلاحية المحل لا يصح الايجاب أصلا.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول هذا الايجاب يتناول أحدهما بغير عينه على احتمال التعيين، ألا ترى أنهما لو كانا عبدين تناول أحدهما على احتمال التعيين إما ببيانه أو بانعدام المزاحمة بموت أحدهما فيصح الايجاب هنا باعتبار هذا المجاز كما هو أصل أبي حنيفة رحمه الله في العمل بالمجاز وإن تعذر العمل بالحقيقة لعدم صلاحية المحل له، وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم، فإذا لم يكن المحل صالحا للحكم حقيقة يسقط اعتبار العمل بالمجاز وقد بينا هذا.
وعلى هذا لو قال لثلاث نسوة له: هذه طالق أو هذه وهذه تطلق الثالثة ويتخير في الاوليين، بمنزلة ما لو جمع بين الاوليين فقال إحداكما طالق وهذه، ولهذا قال زفر رحمه الله في قوله والله لا أكلم فلانا أو فلانا وفلانا إنه لا يحنث إن كلم الاول وحده ما لم يكلم الثالث معه، بمنزلة قوله لا أكلم أحد هذين وهذا.
ولكنا نقول هناك إن كلم الاول وحده يحنث وإن كلم أحد الآخرين لا يحنث ما لم يكلمهما لانه أشرك بينهما بحرف الواو والخبر المذكور يصلح للمثنى كما يصلح للواحد، فإنه يقول لا أكلم هذا لا أكلم هذين فيصير كأنه قال لا أكلم هذا أو هذين، بخلاف الطلاق فهناك الخبر المذكور غير صالح للمثنى إذا جمعت بينهما لانه يقال للمثنى طالقان مع أن هناك يمكن أن تجعل الثالثة كالمذكورة وحدها فإن الحكم فيها لا يختلف سواء ضمت إلى الاولى أو إلى الثانية، وهنا الحكم في الثالث يختلف بالانضمام إلى الاول أو الثاني فكان ضمه إلى ما يليه أولى.
وعلى هذا لو قال وكلت ببيع هذا العبد هذا الرجل أو هذا فإنه يصح التوكيل استحسانا، بمنزلة ما لو قال وكلت أحدهما ببيعه حتى لا يشترط اجتماعهما على البيع، بخلاف ما لو قال وهذا، وإذا باع أحدهما نفذ البيع ولم يكن للآخر بعد ذلك أن يبيعه، وإن عاد إلى ملكه وقبل البيع يباح لكل واحد منهما أن يبيعه.
وكذلك لو قال لواحد بع هذا العبد أو هذا يثبت له الخيار على أن يبيع
أحدهما أيهما شاء، بمنزلة ما لو قال بع أحدهما، فأما في البيع إذا أدخل كلمة
أو في المبيع أو الثمن فالبيع فاسد للجهالة لان موجب الكلمة التخيير ومن له الخيار منهما غير معلوم، فإن كان معلوما جاز في الاثنين والثلاثة استحسانا ولم يجز في الزيادة على ذلك لبقاء الحظر بعد تعين من له الخيار، ولكن اليسير من الحظر لا يمنع جواز العقد والفاحش منه يمنع جواز العقد.
فأما في النكاح ف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقولان يثبت التخيير بهذه الكلمة إذا كان مفيدا بأن يقول لامرأة تزوجتك على ألف درهم حالا أو على ألفين إلى سنة أو تزوجتك على ألف درهم أو مائة دينار، ولا يثبت الخيار إذا لم يكن مفيدا بأن يقول تزوجتك على ألف درهم أو ألفين بل يجب الاقل عينا لانه لا فائدة في التخيير بين القليل والكثير في جنس واحد، وصحة النكاح لا تتوقف على تسمية البدل فوجوب المال عند التسمية في معنى الابتداء، بمنزلة الاقرار بالمال أو الوصية أو الخلع أو الصلح عن دم العمد على مال فإنما يثبت الاقل لكونه متيقنا به، ولهذا كل ما يصلح أن يكون مسمى في الصلح عن دم العمد يصلح أن يكون مسمى في النكاح.
وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول يصار إلى تحكيم مهر المثل لان التخيير الذي هو حكم هذه الكلمة يمنع كون المسمى معلوما قطعا والموجب الاصلي في النكاح مهر المثل وإنما ينتفي ذلك الموجب عند تسمية معلومة قطعا فإذا انعدم ذلك بحرف أو وجب المصير إلى الموجب الاصلي، بخلاف الخلع والصلح فليس في ذلك العقد موجب أصلي في البدل بل هو صحيح من غير بدل يجب به فلهذا أوجبنا القدر الميتقن به وما زاد على ذلك لكونه مشكوكا فيه يبطل.
وعلى هذا قال مالك رحمه الله في حد قطاع الطريق إن الامام يتخير في ظاهر قوله تعالى: (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) فإن موجب الكلمة التخيير والكلام محمول على حقيقته حتى يقوم دليل المجاز.
ولكنا نقول في أول
الآية تنصيص على أن المذكور جزاء على المحاربة، والمحاربة أنواع كل نوع منها معلوم من تخويف أو أخذ مال أو قتل نفس أو جمع بين القتل وأخذ المال، وهذه الانواع تتفاوت في صفة الجناية والمذكور أجزية متفاوتة في معنى التشديد فوقع
الاستغناء بتلك المقدمة عن بيان تقسيم الا جزية على أنواع الجناية نصا، ولكن هذا التقسيم ثابت بأصل معلوم وهو أن الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم البعض على البعض فلهذا كان الجزاء على كل نوع عينا، كيف وقد نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقسيم في أصحاب أبي بردة ؟ ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله إذا جمع بين القتل وأخذ المال فللامام الخيار، إن شاء قطع يده ثم قتله وصلبه، وإن شاء قتله وصلبه ولم يقطعه، لان نوع المحاربة متعدد صورة متحد معنى فيتخير لهذا.
وقيل أو هنا بمعنى بل كما قال الله تعالى: (فهي كالحجارة أو أشد قسوة) أي بل أشد قسوة فيكون المراد بل يصلبوا إذا اتفقت المحاربة بقتل النفس وأخذ المال بل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال فقط بل ينفوا من الارض إذا خوفوا الطريق.
وقد تستعار كلمة أو للعطف فتكون بمعنى الواو، قال تعالى: (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) أي ويزيدون.
قال القائل: فلو كان البكاء يرد شيئابكيت على زياد أو عناق على المرأين إذ مضيا جميعا لشأنهما بحزن واحتراق (أي وعناق) بدليل قوله: على المرأين إذ مضيا جميعا.
إذا عرفنا هذا فنقول إنما يحمل على هذه الاستعارة عند اقتران الدليل بالكلام، ومن الدليل (على ذلك) أن تكون مذكورة في موضع النفي، قال الله تعالى: (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) معناه: ولا كفورا، والدليل فيه ما قدمنا أن النكرة في (موضع) النفي تعم ولا يمكن إثبات التعميم إلا أن يجعل بمعنى واو العطف ولكن
على أن يتناول كل واحد منهما على الانفراد لا على الاجتماع كما هو موجب حرف الواو، ولهذا قلنا لو قال والله أكلم فلانا أو فلانا فإنه يحنث إذا كلم أحدهما، بخلاف قوله فلانا وفلانا فإنه لا يحنث ما لم يكلمهما، ولكن يتناول كل واحد (منهما) على الانفراد حتى لا يثبت له الخيار، ولو كان في الايلاء بأن قال لا أقرب
هذه أو هذه فمضت المدة بانتا جميعا.
ومن ذلك أن يستعمل الكلمة في موضع الاباحة فتكون بمعنى الواو حتى يتناول معنى الاباحة كل واحد من المذكورين، فإن الرجل يقول جالس الفقهاء أو المتكلمين فيفهم (منه) الاذن بالمجالسة مع كل واحد من الفريقين، والطبيب يقول للمريض كل هذا أو هذا فإنما يفهم منه أن كل واحد منهما صالح لك.
وبيان هذا في قوله تعالى: (إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم) فالاستثناء من التحريم إباحة ثم تثبت الاباحة في جميع هذه الاشياء، فعرفنا أن موجب هذه الكلمة في الاباحة العموم وأنه بمعنى واو العطف.
وبيان الفرق بين الاباحة والايجاب أن في الايجاب الامتثال بالاقدام على أحدهما، وفي الاباحة تتحقق الموافقة في الاقدام على كل واحد منهما.
وعلى هذا قلنا إذا قال لا أكلم أحدا إلا فلانا أو فلانا فإن له أن يكلمهما من غير حنث.
ولو قال لاربع نسوة له والله لا أقربكن إلا فلانة أو فلانة فإنه لا يكون موليا منهما جميعا حتى لا يحنث إن قربهما ولا تقع الفرقة بينه وبينهما بمضي المدة قبل القربان.
وقد تستعار أو بمعنى حتى قال تعالى: (ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم) : أي حتى يتوب عليهم.
وفي هذه الاستعارة معنى العطف، فإن غاية الشئ تتصل به كما يتصل المعطوف بالمعطوف عليه، ولهذا قال في الجامع: لو قال والله لادخلن هذه الدار اليوم أو لادخلن هذه الدار فأي الدارين دخل بر في يمينه لانه ذكر الكلمة في موضع الاثبات فيقتضي التخيير في شرط البر.
ولو قال لا أدخل هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار (فأي الدارين دخل حنث في يمينه لانه ذكرها
في موضع النفي فكانت بمعنى ولا.
ولو قال والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار) الاخرى فإن دخل الاولى حنث في يمينه، وإن دخل الثانية أولا بر في يمينه حتى إذا دخل الاولى بعد ذلك لا يحنث بمنزلة قوله لا أدخل هذه الدار حتى أدخل هذه الدار فكأن الدخول في الاخرى غاية ليمينه فإذا دخلها انتهت اليمين، وإن لم يدخلها حتى دخل الاولى حنث لوجود الشرط في حال بقاء اليمين، وإنما
جعلناه هكذا لانه يتعذر اعتبار معنى التخيير فيه للنفي في أحد الجانبين ويتعذر إثبات معنى العطف لعدم المجانسة بين المذكورين فيجعل بمعنى الغاية، لان حرمة الدخول الثابت باليمين يحتمل الامتداد فيليق به ذكر الغاية كما في قوله تعالى: (ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم) فإنه لا يمكن حمل الكلمة على العطف إذ الفعل لا يعطف على الاسم والمستقبل لا يعطف على الماضي، ونفي الامر يحتمل الامتداد فيجعل قوله (أو يتوب) بمعنى الغاية، ولانه نفي الدخول في الدار الاولى فإذا دخل فيها أولا يجعل كأن المذكور آخرا من جنسه نفي فيحنث بالدخول فيها لهذا، وأثبت الدخول في الدار الثانية فإذا دخلها أولا يجعل كأن الاخير من جنسه إثبات كما في قوله لادخلن هذه الدار أو لادخلن هذه الدار.
فصل وأما حتى فهي للغاية باعتبار أصل الوضع بمنزلة إلى، هو المعنى الخاص الذي لاجله وضعت الكلمة، قال تعالى: (هي حتى مطلع الفجر) وقال تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد) وقال تعالى: (حتى يأذن لي أبي) وقال تعالى: (حتى يأتيك اليقين) فمتى كان ما قبلها بحيث يحتمل الامتداد وما بعدها يصلح للانتهاء به كانت عاملة في حقيقة الغاية، ولهذا قلنا إذا حلف أن يلازم غريمه حتى يقضيه ثم فارقه قبل أن يقضيه دينه حنث، لان الملازمة تحتمل الامتداد، وقضاء الدين يصلح منهيا للملازمة.
وقال
في الزيادات: لو قال عبده حر إن لم أضربك حتى تشتكي يدي أو حتى الليل أو حتى تصبح أو حتى يشفع فلان ثم ترك ضربه قبل هذه الاشياء حنث، لان الضرب بطريق التكرار يحتمل الامتداد والمذكور بعد الكلمة صالح للانتهاء فيجعل غاية حقيقة، وإذا أقلع عن الضرب قبل الغاية حنث إلا في موضع يغلب على الحقيقة عرف فيعتبر ذلك، لان الثابت بالعرف ظاهرا بمنزلة الحقيقة، حتى لو قال إن لم أضربك حتى أقتلك أو حتى تموت فهذا على الضرب الشديد باعتبار العرف، فإنه متى كان قصده القتل لا يذكر لفظ الضرب وإنما يذكر ذلك إذا لم يكن قصده القتل وجعل
القتل غاية لبيان شدة الضرب عادة.
ولو قال حتى يغشى عليك أو حتى تبكي فهذا على حقيقة الغاية لان الضرب إلى هذه الغاية معتاد.
وقد تستعمل الكلمة للعطف فإن بين العطف والغاية مناسبة بمعنى التعاقب ولكن مع وجود معنى الغاية فيها.
يقول الرجل جاءني القوم حتى زيد ورأيت القوم حتى زيدا فيكون للعطف مع اعتبار معنى الغاية لانه يفهم بهذا أن زيدا أفضل القوم أو أرذلهم.
وقد يدخل بمعنى العطف على جملة فإن ذكر له خبرا فهو خبره وإلا فخبره من جنس ما سبق.
يقول الرجل مررت بالقوم حتى زيد غضبان، وتقول أكلت السمكة حتى رأسها فهذا مما لم يذكر خبره وهو من جنس ما سبق على احتمال أن يكون هو الاكل أو غيره ولكنه إخبار بأن رأسها مأكول أيضا.
ولو قال حتى رأسها بالنصب كان هذا عطفا، أي وأكلت رأسها أيضا ولكن باعتبار معنى الغاية.
ومثل هذا في الافعال تكون للجزاء إذا كان ما قبلها يصلح سببا لذلك وما بعدها يصلح أن يكون جزاء فيكون بمعنى لام كي، قال تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) أي لكيلا تكون فتنة، وقال تعالى: (وزلزلوا حتى يقول الرسول) والقراءة بالنصب تحتمل الغاية، معناه إلى أن يقول الرسول فيكون قول الرسول نهاية من غير أن يكون بناء على ما سبق كما هو موجب الغاية أنه لا أثر له
فيما جعل غاية له، ويحتمل لكي يقول الرسول، والقراءة بالرفع تكون بمعنى العطف أي ويقول الرسول.
وعلى هذا قال في الزيادات: إذا قال إن لم آتك غدا حتى تغديني فعبدي حر فأتاه فلم يغده لا يحنث، لان الاتيان ليس بمستدام فلا يحتمل الكلمة بمعنى حقيقة الغاية وما بعده يصلح جزاء فيكون المعنى لكي تغديني فقد جعل شرط بره الاتيان على هذا القصد وقد وجد، وكذلك لو قال إن لم تأتني حتى أغديك فأتاه ولم يغده لم يحنث.
وقد يستعار للعطف المحض كما أشرنا إليه في القراءة بالرفع، ولكن هذا إذا كان المذكور بعده لا يصلح للجزاء فيعتبر مجرد المناسبة بين العطف والغاية في الاستعارة.
وعلى هذا قال في الزيادات: إذا قال إن لم آتك حتى أتغدى عندك اليوم أو إن لم تأتني حتى تتغدى عندي اليوم فأتاه ثم لم يتغد عنده في ذلك اليوم حنث، لان الكلمة بمعنى العطف فإن الفعلين من واحد فلا يصلح الثاني أن يكون جزاء للاول فحمل على العطف المحض لتصحيح الكلام، وشرط البر وجود الامرين في اليوم فإذا لم يوجدا حنث.
فإن قيل: أهل النحو لا يعرفون هذا، فإنهم لا يقولون رأيت زيدا حتى عمرا باعتبار العطف ؟ قلنا: قد بينا أن في الاستعارات لا يعتبر السماع وإنما يعتبر المعنى الصالح للاستعارة وما أشرنا إليه من المناسبة معنى صالح لذلك فهي استعارة بديعة بنى علماؤنا رحمهم الله جواب المسألة عليها مع أن قول محمد رحمه الله حجة في اللغة فإن أبا عبيد وغيره احتج بقوله، وذكر ابن السراج أن المبرد سئل عن معنى الغزالة فقال هي الشمس، قاله محمد بن الحسن رحمه الله وكان فصيحا فإنه قال لخادم له يوما: انظر هل دلكت الغزالة ؟ فخرج ثم دخل فقال: لم أر الغزالة.
وإنما أراد محمد هل زالت الشمس ؟ فعلى هذا يجوز أن يقول الرجل رأيت زيدا حتى عمرا بمعنى العطف إلا أن الاولى أن يجعل هذا بمعنى الفاء دون الواو، لان كل واحد منهما للعطف ولكن
في الفاء معنى التعقيب فهو أقرب إلى معنى المناسبة كما بينا.
فصل وأما إلى فهي لانتهاء الغاية، ولهذا تستعمل الكلمة في الآجال والديون، قال تعالى: (إلى أجل مسمى) وعلى هذا لو قال لامرأته أنت طالق إلى شهر، فإن نوى التنجيز في الحال تطلق ويلغو آخر كلامه، وإن نوى التأخير يتأخر الوقوع إلى مضي الشهر، وإن لم يكن له نية فعلى قول زفر رحمه الله يقع في الحال، لان تأخير الشئ لا يمنع ثبوت أصله (فيكون بمنزلة التأجيل في الدين لا يمنع ثبوت أصله) وعندنا لا يقع لان الكلمة للتأخير فيما يقرن به باعتبار أصل الوضع وقد قرنها بأصل الطلاق وأصلها يحتمل التأخير في التعليق بمضي شهر أو بالاضافة إلى ما بعد شهر، فأما أصل اليمين لا يحتمل التأخير في التعليق والاضافة، فلهذا حملنا الكلمة هناك على تأخير المطالبة.
ثم من الغايات بهذه الكلمة ما لا يدخل كقوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) ومنها ما يدخل كقوله: (وأيديكم إلى المرافق) والحاصل فيه أن ما يكون من الغايات قائما بنفسه فإنه لا يدخل لانه حد ولا يدخل الحد في المحدود، ولهذا لو قال لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان في الاقرار،
وما لا يكون قائما بنفسه فإن كان أصل الكلام متناولا للغاية كان ذكر الغاية لاخراج ما وراءها فيبقى موضع الغاية داخلا كما في قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) فإن الاسم عند الاطلاق يتناول الجارحة إلى الابط فذكر الغاية لاخراج ما وراءها، وإن كان أصل الكلام لا يتناول موضع الغاية أو فيه شك فذكر الغاية لمد الحكم إلى موضعها فلا تدخل الغاية كما في قوله تعالى: (إلى الليل) فإن الصوم عبارة عن الامساك ومطلقه لا يتناول إلا ساعة فذكر الغاية لمد الحكم إلى موضع الغاية، ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: الغاية تدخل في الخيار لان مطلقه يقتضي التأبيد ولان في لزوم البيع في موضع الغاية
شكا، وفي الآجال والاجارات لا تدخل الغايات، لان المطلق لا يقتضي التأبيد وفي تأخير المطالبة وتمليك المنفعة في موضع الغاية شك، وفي اليمين إذا حلف لا يكلم فلانا إلى وقت كذا تدخل الغاية في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لان مطلقه يقتضي التأبيد فذكر الغاية لاخراج ما وراءها، ولا تدخل في ظاهر الرواية لان في حرمة الكلام ووجوب الكفارة في الكلام في موضع الغاية شكا.
وعلى هذا قال زفر رحمه الله: إذا قال لفلان علي من درهم إلى عشرة، أو قال لامرأته أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لا تدخل الغايتان لان الغاية حد والمحدود غير الحد.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: تدخل الغايتان لان هذه الغاية لا تقوم بنفسها فلا تكون غاية ما لم تكن ثانية.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: الغاية الثانية لا تدخل لان مطلق الكلام لا يتناوله وفي ثبوته شك، ولكن الغاية الاولى تدخل للضرورة لان الثانية داخلة في الكلام ولا تكون ثانية قبل دخول الاولى.
فصل وأما على فهو للالزام باعتبار أصل الوضع لان معنى حقيقة الكلمة من علو الشئ على الشئ وارتفاعه فوقه وذلك قضية الوجوب واللزوم، ولهذا لو قال لفلان علي ألف درهم أن مطلقه محمول على الدين إلا أن يصل بكلامه وديعة لان
حقيقته اللزوم في الدين.
ثم تستعمل الكلمة للشرط باعتبار أن الجزاء يتعلق بالشرط ويكون لازما عند وجوده.
وبيان هذا في قوله تعالى: (يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا) وقال تعالى: (حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق) وعلى هذا قال في السير: إذا قال رأس الحصن آمنوني على عشرة من أهل الحصن إن العشرة سواه والخيار في تعيينهم إليه لانه شرط ذلك لنفسه بكلمة على، بخلاف ما لو قال آمنوني وعشرة أو فعشرة أو ثم عشرة فالخيار في تعيين العشرة إلى من آمنهم، لان المتكلم
عطف أمانهم على أمان نفسه من غير أن شرط لنفسه في أمانهم شيئا.
وقد تستعار الكلمة بمعنى الباء الذي يصحب الاعواض لما بين العوض والمعوض من اللزوم والاتصال في الوجوب، حتى إذا قال بعت منك هذا الشئ على ألف درهم أو آجرتك شهرا على درهم يكون بمعنى الباء، لان البيع والاجارة لا تحتمل التعليق بالشرط فيحمل على هذا المستعار لتصحيح الكلام، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله، إذا قالت المرأة لزوجها طلقني ثلاثا على ألف درهم فطلقها واحدة يجب ثلث الالف، بمنزلة ما لو قالت بألف درهم لان الخلع عقد معاوضة.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول لا يجب عليها شئ من الالف ويكون الواقع رجعيا لان الطلاق يحتمل التعليق بالشرط وإن كان مع ذكر العوض، ولهذا كان بمنزلة اليمين من الزوج حتى لا يملك الرجوع عنه قبل قبولها، وحقيقة الكلمة للشرط فإذا كانت مذكورة فيما يحتمل معنى الشرط يحمل عليه دون المجاز وعلى اعتبار الشرط لا يلزمها شئ من المال لانها شرطت إيقاع الثلاث ليتم رضاها بالتزام المال والشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله أجزاء، وقد يكون على بمعنى من، قال تعالى: (إذا اكتالوا على الناس يستوفون) أي من الناس.
فصل وكلمة من للتبعيض باعتبار أصل الوضع، وقد تكون لابتداء الغاية، يقول الرجل خرجت من الكوفة، وقد تكون للتمييز يقال باب من حديد وثوب من قطن، وقد تكون بمعنى الباء، قال تعالى: (يحفظونه من أمر الله) أي بأمر الله، وقد تكون صلة، قال تعالى: (يغفر لكم من ذنوبكم) وقال تعالى: (فاجتنبوا الرجس
من الاوثان) وفي حملة على الصلة يعتبر تعذر حمله على معنى وضع له باعتبار الحقيقة أو يستعار له مجازا وتعتبر الحاجة إلى إتمام الكلام به لئلا يخرج من أن يكون
مفيدا.
وعلى هذا قال في الجامع: إن كان ما في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فإذا في يده أربعة فهو حانث لان الدرهم الرابع بعض الدراهم وكلمة من للتبعيض.
ولو قالت المرأة لزوجها اخلعني على ما في يدي من الدراهم فإذا في يدها درهم أو درهمان تلزمها ثلاثة دراهم لان من هنا صلة لتصحيح الكلام فإن الكلام لا يصح إلا بها، حتى إذا قالت اخلعني على ما في يدي دراهم كان الكلام مختلا، وفي الاول لو قال إن كان في يدي دراهم كان الكلام صحيحا فعمل الكلمة في التبعيض لا في تصحيح الكلام.
وقد بينا المسائل على هذه الكلمة فيما سبق.
فصل وأما في فهي للظرف باعتبار أصل الوضع، يقال دراهم في صرة.
وعلى اعتبار هذه الحقيقة قلنا إذا قال لغيره غصبتك ثوبا في منديل أو تمرا في قوصرة يلزمه رد كليهما لانه أقر (بغصب مظروف في ظرف فلا يتحقق ذلك إلا) بغصبه لهما.
ثم الظرف أنواع ثلاثة: ظرف الزمان وظرف المكان وظرف الفعل.
فأما ظرف الزمان فبيانه فيما إذا قال لامرأته أنت طالق في غد فإنها تطلق غدا باعتبار أنه جعل الغد ظرفا، وصلاحية الزمان ظرفا للطلاق من حيث إنه يقع فيه فتصير موصوفة في ذلك الزمان بأنها طالق فعند الاطلاق كما طلع الفجر تطلق فتتصف بالطلاق في جميع الغد بمنزلة ما لو قال أنت طالق غدا، وإن قال نويت آخر النهار لم يصدق عندهما في القضاء كما في قوله غدا، لانه نوى التخصيص فيما يكون موجبه العموم.
وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يدين في القضاء لان ذكر حرف الظرف دليل على أن المراد جزء من الغد فالوقوع إنما يكون في جزء ولكن ذلك الجزء مبهم في كلامه فعند عدم النية قلنا كما وجد جزء من الغد تطلق فإذا نوى آخر النهار كان هذا بيانا للمبهم وهو مصدق في بيان مبهم كلامه في القضاء بخلاف قوله غدا فاللفظ هناك
متناول لجميع الغد فنية آخر النهار تكون تخصيصا، وعلى هذا لو قال إن صمت الشهر فهو على صوم جميع الشهر، ولو قال إن صمت في الشهر فهو على صوم ساعة باعتبار المعنى الذي قلنا.
وأما ظرف المكان فبيانه في قوله أنت طالق في الدار أو في الكوفة فإنه يقع الطلاق عليها حيثما تكون، لان المكان لا يصلح ظرفا (للطلاق) فإن الطلاق إذا وقع في مكان فهو واقع في الامكنة كلها وهي إذا اتصفت بالطلاق في مكان تتصف به في الامكنة كلها إلا أن يقول عنيت إذا دخلت فحينئذ لا يقع الطلاق ما لم تدخل باعتبار أنه كنى بالمكان عن الفعل الموجود فيه أو أضمر الفعل في كلامه فكأنه قال أنت طالق في دخولك الدار، وهذا هو ظرف الفعل على معنى أن الفعل لا يصلح ظرفا للطلاق حقيقة ولكن بين الظرف والشرط مناسبة من حيث المقارنة أو من حيث تعلق الجزاء بالشرط بمنزلة قوام المظروف بالظرف فتصير الكلمة بمعنى الشرط مجازا.
ثم إن كان الفعل سابقا أو موجودا في الحال يكون تنجيزا، وإن كان منتظرا يتعلق الوقوع بوجوده كما هو حكم الشرط.
وعلى هذا لو قال أنت طالق في حيضتك وهي حائض تطلق في الحال، وإن قال أنت طالق في مجئ حيضتك فإنها لا تطلق حتى تحيض.
وقال في الجامع: إذا قال أنت طالق في مجئ يوم لم تطلق حتى يطلع الفجر من الغد، ولو قال في مضي يوم، فإن قال ذلك بالليل فهي طالق كما غربت الشمس من الغد، وإن قال ذلك بالنهار لم تطلق حتى يجئ مثل هذه الساعة من الغد.
وعلى هذا قال في السير الكبير: إذا قال رأس الحصن آمنوني في عشرة فهو أحد العشرة لان معنى الظرف في العدد بهذا يتحقق، والخيار في التسعة إلى الذي آمنهم لا إليه، لانه ما شرط لنفسه شيئا في أمان من ضمهم إلى نفسه ليكونوا عشرة.
ولو قال لفلان علي عشرة دراهم في عشرة تلزمه عشرة لان العدد لا يصلح ظرفا لمثله بلا شبهة إلا أن يعني حرف مع فإن في يأتي بمعنى مع، قال تعالى:
(فادخلي في عبادي) أي مع عبادي، فإذا قال ذلك فحينئذ يلزمه عشرون، ولكن
بدون هذه النية لا يلزمه لان المال بالشك لا يجب.
وكما أن في يكون بمعنى مع يكون بمعنى من، قال تعالى: (وارزقوهم فيها) أي منها.
وكذلك لو قال لامرأته أنت طالق واحدة في واحدة فهي طالق واحدة إلا أن يقول نويت مع فحينئذ تطلق اثنتين دخل بها أم لم يدخل بها، وإن قال عنيت الواو فذلك صحيح أيضا على ما هو مذهب أهل النحو أن أكثر حروف الصلات يقام بعضها مقام بعض، فعند هذه النية تطلق اثنتين إن كان دخل بها وواحدة إن لم يدخل بها، بمنزلة قوله واحدة وواحدة.
وقال في الزيادات: إذا قال أنت طالق في مشيئة الله أو في إرادته لم تطلق بمنزلة قوله إن شاء الله كما جعل قوله في دخولك الدار بمنزلة قوله إن دخلت الدار، إلا في قوله في علم الله فإنها تطلق لان العلم يستعمل عادة بمعنى المعلوم، يقال علم أبي حنيفة، ويقول الرجل اللهم اغفر لنا علمك فينا: أي معلومك، وعلى هذا المعنى يستحيل جعله بمعنى الشرط.
فإن قيل: لو قال في قدرة الله لم تطلق، وقد تستعمل القدرة بمعنى المقدور، فقد يقول من يستعظم شيئا: هذه قدرة الله تعالى.
قلنا: معنى هذا الاستعمال أنه أثر قدرة الله تعالى إلا أنه قد يقام المضاف إليه مقام المضاف ومثله لا يتحقق في العلم.
ومن هذا الجنس أسماء الظروف، وهي: مع، وقبل، وبعد، وعند.
فأما مع فهي للمقارنة حقيقة وإن كان قد تستعمل بمعنى بعد، قال تعالى: (إن مع العسر يسرا) وعلى اعتبار حقيقة الوضع قلنا إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة مع واحدة تطلق اثنتين سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وكذلك لو قال معها واحدة لانهما تقترنان في الوقوع في الوجهين.
ولو قال لفلان علي مع كل درهم من هذه الدراهم العشرة درهم فعليه عشرون درهما.
وأما قبل فهي للتقديم، قال تعالى: (من قبل أن نطمس وجوها) ولهذا لو قال لامرأته وقت الضحوة أنت طالق قبل غروب الشمس تطلق للحال، بخلاف
الملك الذي كان للمورث، فإن الوراثة خلافة، وقد بينا أن عنده استصحاب الحال فيما يرجع إلى الابقاء حجة على الغير.
ولكنا نقول: هذا البقاء في حق المورث، فأما في حق الوارث فصفة المالكية تثبت له ابتداء واستصحاب الحال لا يكون حجة فيه بوجه، وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا ادعى عينا في يد إنسان أنه له ميراث من أبيه وأقام الشاهدين فشهدا أن هذا كان لابيه لم تقبل هذه الشهادة.
وفي قول أبي يوسف الآخر تقبل، لان الوراثة خلافة فإنما يبقى للوارث الملك الذي كان للمورث، ولهذا يرد بالعيب ويصير مغرورا فيما اشتراه المورث، وما ثبت فهو باق لاستغناء البقاء عن دليل.
وهما يقولان في حق الوارث: هذا في معنى ابتداء التملك، لان صفة المالكية تثبت له في هذا المال بعد أن لم يكن مالكا، وإنما يكون البقاء في حق المورث أن لو حضر بنفسه يدعي أن العين ملكه فلا جرم إذا شهد الشاهدان أنه كان له كانت شهادة مقبولة كما إذا شهدا أنه له، فأما إذا كان المدعي هو الوارث وصفة المالكية للوارث تثبت ابتداء بعد موت المورث فهذه الشهادة لا تكون حجة للقضاء بالملك له، لان طريق القضاء بها استصحاب الحال وذلك غير صحيح.
فصل ومن هذه الجملة الاستدلال بتعارض الاشباه، وذلك نحو احتجاج زفر رحمه الله في أنه لا يجب غسل المرافق في الوضوء، لان من الغايات ما يدخل ومنها ما لا يدخل فمع الشك لا تثبت فرضية الغسل فيما هو غاية بالنص، لان
هذا في الحقيقة احتجاج بلا دليل لاثبات حكم، فإن الشك الذي يدعيه أمر حادث فلا يثبت حدوثه إلا بدليل.
فإن قال: دليله تعارض الاشباه.
قلنا: وتعارض الاشباه أيضا حادث فلا يثبت إلا بالدليل.
فإن قال: الدليل عليه ما أعده من الغايات مما يدخل بالاجماع وما لا يدخل بالاجماع.
قلنا: وهل تعلم أن هذا المتنازع فيه من أحد النوعين بدليل ؟ فإن قال أعلم ذلك.
قلنا: فإذن عليك أن لا تشك فيه بل
تلحقه بما هو من نوعه بدليله.
وإن قال: لا أعلم ذلك.
قلنا: قد اعترفت بالجهل، فإن كان هذا مما يمكن الوقوف عليه بالطلب فإنما جهلته عن تقصير منك في طلبه وذلك لا يكون حجة أصلا، وإن كان مما لا يمكن الوقوف عليه بعد الطلب كنت معذورا في الوقوف فيه، ولكن هذا العذر لا يصير حجة لك على غيرك ممن يزعم أنه قد ظهر عنده دليل إلحاقه بأحد النوعين، فعرفنا أن حاصل كلامه احتجاج بلا دليل.
فصل ومن هذه الجملة الاحتجاج بالاطراد على صحة العلة إما وجودا أو وجودا وعدما فإنه احتجاج بلا دليل في الحقيقة، ومن حيث الظاهر هو احتجاج بكثرة أداء الشهادة، وقد بينا أن كثرة أداء الشهادة وتكرارها من الشاهد لا يكون دليل صحة شهادته.
ثم الاطراد عبارة عن سلامة الوصف عن النقوض والعوارض، والناظر وإن بالغ في الاجتهاد بالعرض على الاصول المعلومة عنده فالخصم لا يعجز من أن يقول عندي أصل آخر هو مناقض لهذا الوصف أو معارض فجهلك به لا يكون حجة لك علي، فتبين من هذا الوجه أنه احتجاج بلا دليل، ولكنه فوق ما تقدم في الاحتجاج به من حيث الظاهر، لان من حيث الظاهر الوصف صالح، ويحتمل أن يكون حجة للحكم إذا ظهر أثره عند التأمل،
ولكن لكونه في الحقيقة استدلالا على صحته بعدم النقوض والعوارض لم يصلح أن يكون حجة لاثبات الحكم.
فإن قيل: أليس أن النصوص بعد ثبوتها يجب العمل بها، واحتمال ورود الناسخ لا يمكن شبهة في الاحتجاج بها قبل أن يظهر الناسخ فكذلك ما تقدم ؟ قلنا: أما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا احتمال للنسخ في كل نص كان حكمه ثابتا عند وفاته، فأما في حال حياته فهكذا نقول: إن الاحتجاج به لاثبات الحكم ابتداء صحيح، فأما لابقاء الحكم أو لنفي الناسخ لا يكون صحيحا، لان احتمال بقاء الحكم واحتمال قيام دليل النسخ فيه كان بصفة واحدة، وقد قررنا هذا في باب النسخ.
مبيعا والمبيع الدين لا يكون إلا سلما، وعلى هذا لو قال لعبده إن أخبرتني بقدوم فلان فأنت حر، فهذا على الخبر الحق الذي يكون بعد القدوم، لان مفعول الخبر محذوف هنا وقد دل عليه حرف الباء الذي هو للالصاق، كقول القائل: بسم الله، أي بدأت بسم الله فيكون معنى كلامه إن أخبرتني خبرا ملصقا بقدوم فلان، والقدوم اسم لفعل موجود فلا يتناول الخبر بالباطل.
ولو قال إن أخبرتني أن فلانا قد قدم فهذا على الخبر حقا كان أو باطلا، لانه لما لم يذكر حرف الباء فالمذكور صالح لان يكون مفعول الخبر وأن وما بعده مصدر والخبر إنما يكون بكلام لا يفعل فكأنه قال إن أخبرتني بخبر قدوم فلان، والخبر اسم لكلام يدل على القدوم ولا يوجد عنده القدوم لا محالة.
وعلى هذا قال في الزيادات: إذا قال أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بحكمه لم تطلق، وكذلك سائر أخواتها، لان الباء للالصاق فيكون دليلا على معنى الشرط مفضيا إليه.
وعلى هذا قال في الجامع: إذا قال لامرأته إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني تحتاج إلى الاذن في كل مرة، لان الباء للالصاق
فإنما جعل المستثنى خروجا ملصقا بالاذن وذلك لا يكون إلا بتجديد الاذن في كل مرة، قال تعالى: (وما نتنزل إلا بأمر ربك) أي مأمورين بذلك.
ولو قال إن خرجت إلا أن آذن لك، فهذا على الاذن مرة (واحدة) لانه يتعذر الحمل ههنا على الاستثناء لمخالفة الجنس في صيغة الكلام فيحمل على معنى الغاية مجازا لما بينهما من المناسبة، وعليه دل قوله تعالى: (إلا أن يحاط بكم) .
(إلا أن تقطع قلوبهم) : أي حتى.
ثم قال الشافعي في قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) : إن الباء للتبعيض فإنما يلزمه مسح بعض الرأس وذلك أدنى ما يتناوله الاسم.
وقال مالك: الباء صلة للتأكيد بمنزلة قوله تعالى: (تنبت بالدهن) كأنه قال وامسحوا رؤوسكم فيلزمه مسح جميع الرأس.
وقلنا: أما التبعيض فلا وجه له لان الموضوع للتبعيض حرف من والتكرار والاشتراك لا يثبت بأصل الوضع، ولا وجه لحمله على الصلة لما فيه من معنى الالغاء أو الحمل على غير فائدة مقصودة
وهي التوكيد.
ولكنا نقول: الباء للالصاق باعتبار أصل الوضع، فإذا قرنت بآلة المسح يتعدى الفعل بها إلى محل المسح فيتناول جميعه كما يقول الرجل: مسحت الحائط بيدي ومسحت رأس اليتيم بيدي فيتناول كله، وإذا قرنت بمحل المسح يتعدى الفعل بها إلى الآلة فلا تقتضي الاستيعاب وإنما تقتضي إلصاق الآلة بالمحل وذلك لا يستوعب الكل عادة، ثم أكثر الآلة ينزل منزلة الكمال، فيتأدى المسح بإلصاق ثلاثة أصابع بمحل المسح، ومعنى التبعيض إنما يثبت بهذا الطريق لا بحرف الباء.
فإن قيل: أليس أن في التيمم حكم المسح ثبت بقوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ثم الاستيعاب فيه شرط ؟ قلنا: أما على رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يشترط فيه الاستيعاب لهذا المعنى، وأما على ظاهر الرواية فإنما عرفنا
الاستيعاب هناك إما بإشارة الكتاب وهو أن الله تعالى أقام التيمم في هذين العضوين مقام الغسل عند تعذر الغسل والاستيعاب في الغسل فرض بالنص فكذلك فيما قام مقامه، أو عرفنا ذلك بالسنة وهو قوله عليه السلام لعمار رضي الله عنه: يكفيك ضربتان: ضربة للوجه وضربة للذراعين.
ومن هذا الفصل حروف القسم، والاصل فيها باعتبار الوضع الباء حتى يستقيم استعمالها مع إظهار الفعل ومع إضماره، فإن الباء للالصاق وهي تدل على محذوف كما بينا، وقول الرجل بالله بمعنى أقسم (أو أحلف) بالله كما قال تعالى: (يحلفون بالله ما قالوا) وكذلك يستقيم وصلها بسائر الاسماء والصفات وبغير الله إذا حلف به مع التصريح بالاسم أو الكناية عنه بأن يقول بأبي أو بك لافعلن أو به لافعلن فيصح استعماله في جميع هذه الوجوه لمقصود القسم باعتبار أصل الوضع.
ثم قد تستعار الواو مكان الباء في صلة القسم لما بينهما من المناسبة صورة ومعنى.
أما الصورة فلان خروج كل واحد منهما من المخرج الصحيح بضم الشفتين، وأما المعنى فلان في العطف إلصاق المعطوف بالمعطوف عليه، وحرف الباء للالصاق إلا أن الواو تستعمل في المضمر (دون المظهر، لا يقال أحلف والله لانه يشبه قسمين،
بينهما بعضية، وفي المبتوتة إنه لا يلحقها الطلاق لانه ليس بينهما نكاح، وفي إسلام المروي بالمروي إنه يجوز لانه لم يجمع البدلين الطعم والثمنية، وهذا فاسد لانه استدلال بعدم وصف والعدم لا يصلح أن يكون موجبا حكما، وقد بينا أن العدم الثابت بدليل لا يكون بقاؤه ثابتا بدليل فكيف يستدل به لاثبات حكم آخر.
فإن قيل: مثل هذا التعليل كثير في كتبكم.
قال محمد رحمه الله: ملك النكاح لا يضمن بالاتلاف لانه ليس بمال، والزوائد لا تضمن بالغصب لانه
لم يغصب الولد.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: العقار لا يضمن بالغصب لانه لم ينقله ولم يحوله.
وقال فيما لا يجب فيه الخمس: لانه لم يوجف عليه المسلمون.
وقال في تناول الحصاة: لا تجب الكفارة لانه ليس بمطعوم.
وقال في الجد: لا يؤدي صدقة الفطر عن النافلة لانه ليس عليه ذلك.
فهذا استدلال بعدم وصف أو حكم.
قلنا: أولا هذا عندنا غير مذكور على وجه المقايسة بل على وجه الاستدلال فيما كان سببه واحدا معينا بالاجماع نحو الغصب، فإن ضمان الغصب سببه واحد عين وهو الغصب، فالاستدلال بانتفاء الغصب على انتفاء الضمان يكون استدلالا بالاجماع.
وكذلك وجوب ضمان المال بسبب يستدعي المماثلة بالنص وله سبب واحد عين وهو إتلاف المال، فيستقيم الاستدلال بانتفاء المالية في المحل على انتفاء هذا النوع من الضمان وكذلك إذا كان دليل الحكم معلوما في الشرع بالاجماع نحو الخمس فإنه واجب في الغنيمة لا غير وطريق الاغتنام الايجاف عليه بالخيل والركاب، فالاستدلال به لنفي الخمس يكون استدلالا صحيحا، وقد بينا أنه إبلاء العذر في بعض المواضع لا الاحتجاج به على الخصم.
فأما تعليل النكاح بأنه ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال يكون تعليلا بعدم الوصف وعدم الوصف لا يعدم الحكم لجواز أن يكون الحكم ثابتا باعتبار وصف آخر، لانه وإن لم يكن مالا فهو من جنس ما يثبت مع الشبهات والاصل المتفق عليه الحدود والقصاص، وبهذا الوصف لا يصير النكاح بمنزلة الحدود والقصاص حتى يثبت مع الشبهات بخلاف الحدود والقصاص، فعرفنا أن بعدم هذا الوصف لا ينعدم وصف آخر يصلح التعليل به لاثباته بشهادة
النساء مع الرجال.
وكذلك ما علل به من أخوات هذا الفصل فهو يخرج على هذا الحرف إذا تأملت.
فصل ومن هذا النوع الاحتجاج بأن الاوصاف محصورة عند القائسين، فإذا قامت الدلالة على فساد سائر الاوصاف إلا وصفا واحدا تثبت به صحة ذلك الوصف ويكون حجة.
هذا طريق بعض أصحاب الطرد.
وقد جوز الجصاص رحمه الله تصحيح الوصف للعلة بهذا الطريق.
قال الشيخ رحمه الله: وقد كان بعض أصدقائي عظيم الجد في تصحيح هذا الكلام، بعلة أن الاوصاف لما كانت محصورة وجميعها ليست بعلة للحكم بل العلة وصف منها، فإذا قام الدليل على فساد سائر الاوصاف سوى واحد منها ثبت صحة ذلك الوصف بدليل الاجماع كأصل الحكم، فإن العلماء إذا اختلفوا في حكم حادثة على أقاويل، فإذا ثبت بالدليل فساد سائر الاقاويل إلا واحدا ثبت صحة ذلك القول، وذلك نحو اختلاف العلماء في جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه، فإنا إذا أفسدنا قول من يقول بالرجوع إلى قول القائف، وقول من يقول بالقرعة، وقول من يقول بالتوقف إنه لا يثبت النسب من واحد منهما يثبت به صحة قول من يقول بأنه يثبت النسب منهما جميعا.
وإذا قال لنسائه الاربعة: إحداكن طالق ثلاثا ووطئ ثلاثا منهن حتى يكون ذلك دليلا على انتفاء المحرمة عنهن تعين بها الرابعة محرمة فكان تقرب هذا من الادلة العقلية.
قال الشيخ: وعندي أن هذا غلط لا نجوز القول به، وهو مع ذلك نوع من الاحتجاج بالدليل.
أما بيان الغلط فيه وهو أن ما يجعله هذا القائل دليل صحة علته هو الدليل على فساده، لانه لا يمكنه سلوك هذا الطريق إلا بعد قوله بالمساواة بين الاوصاف في أن كل وصف منها صالح أن يكون علة للحكم، وبعد ثبوت هذه المساواة فالدليل الذي يدل على فساد بعضها هو الدليل على فساد ما بقي منها، لانه متى علم المساواة بين شيئين في الحكم ثم ظهر لاحدهما حكم بالدليل فذلك الدليل يوجب مثل
فيجازي بها مرة إذا أريد بها الشرط ولا يجازي بها مرة إذا أريد بها الوقت، وإذا استعملت للشرط لم يكن فيها معنى الوقت، وهذا قول أبي حنيفة، وعلى قول نحويي البصرة هي للوقت باعتبار أصل الوضع، وإن استعملت للشرط فهي لا تخلو عن معنى الوقت، بمنزلة متى فإنها للوقت وإن كان قد يجازي بها، فإن المجازاة بها لازمة في غير موضع الاستفهام والمجازاة بإذا جائزة غير لازمة، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.
وبيان المسألة ما إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق أو إذا ما لم أطلقك، فإن عنى بها الوقت تطلق في الحال، وإن عنى الشرط لم تطلق حتى تموت، وإن لم تكن له نية فعلى قول أبي حنيفة لا تطلق حتى يموت، وعلى قولهما تطلق في الحال، قالا إن إذا تستعمل للوقت غالبا وتقرن بما ليس فيه معنى الخطر، فإنه يقال الرطب إذا اشتد الحر والبرد إذا جاء الشتاء، ولا يستقيم مكانها إن، قال تعالى: (إذا الشمس كورت) و (إذا السماء انفطرت) وذلك كائن لا محالة، فعرفنا أنه لا ينفك عن معنى الوقت استعمالا.
وتستعمل في جواب الشرط، قال تعالى: (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون) وما يستعمل في المجازاة لا يكون محض الشرط، فعرفنا أنها بمعنى متى فإنها لا تنفك عن معنى الوقت وإن كان المجازاة بها ألزم من المجازاة بإذا.
وإذا ثبت هذا قلنا قد أضاف الطلاق إلى وقت في المستقبل هو خال عن إيقاع الطلاق فيه عليها وكما سكت فقد وجد ذلك الوقت فتطلق، ألا ترى أنه لو قال لامرأته إذا شئت فأنت طالق لم تتوقت المشيئة بالمجلس بمنزلة قوله متى شئت، بخلاف قوله إن شئت، وأبو حنيفة رحمه الله اعتمد ما قال أهل الكوفة إن إذا قد تستعمل بمحض الشرط، واستدل عليه الفراء بقول القائل: استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحمل معناه إن تصبك خصاصة، فإن حمل على معنى الشرط لم يقع الطلاق حتى يموت،
وإن حمل على معنى الوقت وقع الطلاق في الحال والطلاق بالشك لا يقع.
وعلى هذا قلنا في قوله إذا شئت إنه لا يتوقت بالمجلس لان المشيئة صارت إليها بيقين، فلو جعلنا الكلمة بمنزلة إن خرج الامر من يدها بالقيام، ولو جعلناها بمنزلة متى لم يخرج الامر من يدها بالشك.
وأما متى فهي للوقت باعتبار أصل الوضع ولكن لما كان الفعل يليها دون الاسم جعلناها في معنى الشرط ولهذا صح المجازاة بها غير أنها لا تنفك عن معنى الوقت بحال، فإذا قال لامرأته متى لم أطلقك فأنت طالق أو متى ما لم أطلقك فأنت طالق طلقت كما سكت لوجود وقت بعد كلامه لم يطلقها فيه، ولهذا لم نذكر في حروف الشرط كلمة كل لان الاسم يليها دون الفعل فإنها تجمع الاسماء ويستقيم أن يقال كل رجل ولا يستقيم أن يقال كل دخل، وفيها معنى الشرط باعتبار أن الاسم الذي يتعقبها يوصف بفعل لا محالة ليتم كل الكلام وذلك الفعل يصير في معنى الشرط حتى لا ينزل الجزاء إلا بوجوده.
بيانه فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها وكل عبد أشتريه، وذكرنا في حروف الشرط كلمة كلما لان الفعل يتعقبها دون الاسم.
يقال كلما دخل وكلما خرج ولا يقال كلما زيد.
وقد قدمنا الكلام في بيان كلما ومن وما.
ومما هو في معنى الشرط لو على ما يروى عن أبي يوسف أنه إذا قال لامرأته أنت طالق لو دخلت الدار لم تطلق ما لم تدخل كقوله إن دخلت لان لو تفيد معنى الترقب فيما يقرن به مما يكون في المستقبل فكان بمعنى الشرط من هذا الوجه.
ولو قال أنت طالق لو حسن خلقك عسى أن أراجعك تطلق في الحال لان لو هنا إنما تقرن بالمراجعة التي تترقب في المستقبل فتخلو كلمة الايقاع عن معنى الشرط.
وأما لولا فهي بمعنى الاستثناء لانها تستعمل لنفي شئ بوجود غيره، قال تعالى: (ولولا رهطك لرجمناك) وعلى هذا قال محمد رحمه الله في قوله أنت طالق لولا
دخولك الدار إنها لا تطلق وتجعل هذه الكلمة بمعنى الاستثناء، ذكره الكرخي رحمه الله في المختصر.
وبالاخرى إلى فروع أخر فلا يكون انعدام العلة مع بقاء الحكم في موضع ثابتا بالعلة الاخرى دليل فساد العلة.
فأما المفارقة فمن الناس من ظن أنها مفاقهة، ولعمري المفارقة مفاقهة ولكن في غير هذا الموضع، فأما على وجه الاعتراض على العلل المؤثرة تكون مجادلة لا فائدة فيها في موضع النزاع.
وبيان هذا من وجوه ثلاثة: أحدها أن شرط صحة القياس لتعدية الحكم إلى الفروع تعليل الاصل ببعض أوصافه لا بجميع أوصافه، وقد بينا أنه متى كان التعليل بجميع أوصاف الاصل لا يكون مقايسة، فبيان المفارقة بين الاصل والفرع بذكر وصف آخر لا يوجد ذلك في الفرع ويرجع إلى بيان صحة المقايسة، فأما أن يكون ذلك اعتراضا على العلة فلا.
ثم ذكر وصف آخر في الاصل يكون ابتداء دعوى والسائل جاهل مسترشد في موقف المنكر إلى أن تتبين له الحجة لا في موضع الدعوى، وإن اشتغل بإثبات دعواه فذلك لا يكون سعيا في إثبات الحكم المقصود وإنما يكون سعيا في إثبات الحكم في الاصل وهو مفروغ عنه، ولا يتصل ما يثبته بالفرع إلا من حيث إنه ينعدم ذلك المعنى في الفرع وبالعدم لا يثبت الاتصال، وقد بينا أن العدم لا يصلح أن يكون موجبا شيئا، فكان هذا منه اشتغالا بما لا فائدة فيه.
والثالث ما بينا أن الحكم في الاصل يجوز أن يكون معلولا بعلتين ثم يتعدى الحكم إلى بعض الفروع بإحدى العلتين دون الاخرى، فبان انعدام في الفرع الوصف الذي يروم به السائل الفرق، وإن سلم له أنه علة لاثبات
الحكم في الاصل فذلك لا يمنع المجيب من أن يعدي حكم الاصل إلى الفرع بالوصف الذي يدعيه أنه علة للحكم، وما لا يكون قدحا في كلام المجيب فاشتغال السائل به يكون اشتغالا بما لا يفيد، وإنما المفاقهة في الممانعة حتى يبين المجيب تأثير علته، فالفقه حكمة باطنة، وما يكون مؤثرا في إثبات الحكم شرعا فهو الحكمة الباطنة، والمطالبة به تكون مفاقهة،
فأما الاعراض عنه والاشتغال بالفرق يكون قبولا لما فيه احتمال أن لا يكون حجة لاثبات الحكم، واشتغالا بإثبات الحكم بما ليس بحجة أصلا في موضع النزاع وهو عدم العلة، فتبين أن هذا ليس من المفاقهة في شئ، والله أعلم.
فصل: الممانعة قال رضي الله عنه: اعلم بأن الممانعة أصل الاعتراض على العلة المؤثرة من حيث إن الخصم المجيب يدعي أن حكم الحادثة ما أجاب به، فإذا لم يسلم له ذلك يذكر وصفا يدعي أنه علة موجبة للحكم في الاصل المجمع عليه وأن هذا الفرع نظير ذلك الاصل، فيتعدى ذلك الحكم بهذا الوصف إلى الفرع، وفي هذا الحكم دعويان فهو أظهر في الدعوى من الاول، أي حكم الحادثة، وإن كانت المناظرة لا تتحقق إلا بمنع دعوى السابق عرفنا أنها لا تتحقق إلا بمنع هذه الدعاوى أيضا فيكون هو محتاجا إلى إثبات دعاويه بالحجة، والسائل منكر فليس عليه سوى المطالبة لاقامة الحجة بمنزلة المنكر في باب الدعاوى والخصومات، وإليه أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم حيث قال للمدعي: (ألك بينة) وبالممانعة يتبين العوارض ويظهر المدعي من المنكر، والملزم من الدافع بعدما ثبت شرعا أن حجة أحدهما
غير حجة الآخر.
ثم الممانعة على أربعة أوجه: ممانعة في نفس العلة، وممانعة في الوصف الذي يذكر العلل أنه علة، وممانعة في شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك الوصف، وممانعة في المعنى الذي به صار ذلك الوصف علة للحكم.
أما الممانعة في نفس العلة فكما بينا أن كثيرا من العلل إذا تأملت فيها تكون احتجاجا بلا دليل، وذلك لا يكون حجة على الخصم الاثبات.
باب: بيان الاحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي قال رضي الله عنه: هذه الاحكام تنقسم أربعة أقسام: الثابت بعبارة النص، والثابت بإشارته، والثابت بدلالته، والثابت بمقتضاه.
فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لاجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له، والثابت بالاشارة ما لم يكن السياق لاجله لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان وبه تتم البلاغة ويظهر الاعجاز.
ونظير ذلك من المحسوس أن ينظر الانسان إلى شخص هو مقبل عليه ويدرك آخرين بلحظات بصره يمنة ويسرة وإن كان قصده رؤية المقبل إليه فقط، ومن رمى سهما إلى صيد فربما يصيب الصيدين بزيادة حذقه في ذلك للعمل، فإصابته الذي قصد منهما موافق للعادة، وإصابة الآخر فضل على ما هو العادة حصل بزيادة حذقه ومعلوم أنه يكون مباشرا فعل الاصطياد فيهما، فكذلك هنا الحكم الثابت بالاشارة والعبارة كل واحد منهما يكون ثابتا بالنص وإن كان عند التعارض قد يظهر بين الحكمين تفاوت كما نبينه.
وبيان هذين النوعين في قوله تعالى: (للفقراء المهاجرين) فالثابت بالعبارة في هذه الآية نصيب من الفئ لهم لان سياق الآية لذلك، كما قال تعالى في أول الآية: (ما أفاء الله على رسوله) الآية، والثابت بالاشارة أن الذين هاجروا من مكة قد
زالت أملاكهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار عليها، فإن الله تعالى سماهم فقراء والفقير حقيقة من لا يملك المال لا من بعدت يده عن المال، لان الفقر ضد الغنى والغني من يملك حقيقة المال لا من قربت يده من المال حتى لا يكون المكاتب غنيا حقيقة وإن كان في يده أموال، وابن السبيل غني حقيقة وإن بعدت يده عن المال لقيام ملكه، ومطلق الكلام محمول على حقيقته، وهذا حكم ثابت بصيغة الكلام من غير زيادة ولا نقصان، فعرفنا أنه ثابت بإشارة النص ولكن لما كان لا يتبين ذلك إلا بالتأمل اختلف العلماء فيه لاختلافهم في التأمل، ولهذا قيل: الاشارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من التصريح أو بمنزلة المشكل من الواضح، فمنه ما يكون
موجبا للعلم قطعا بمنزلة الثابت بالعبارة، ومنه ما لا يكون موجبا للعلم وذلك عند اشتراك معنى الحقيقة والمجاز في الاحتمال مرادا بالكلام.
ومن ذلك قوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فالثابت بالعبارة ظهور المنة للوالدة على الولد لان السياق يدل على ذلك، والثابت بالاشارة أن أدنى مدة الحمل ستة أشهر فقد ثبت بنص آخر أن مدة الفصال حولان كما قال تعالى: (وفصاله في عامين) فإنما يبقى للحمل ستة أشهر ولهذا خفي ذلك على أكثر الصحابة رضي الله عنهم واختص بفهمه ابن عباس رضي الله عنهما فلما ذكر لهم ذلك قبلوا منه واستحسنوا قوله.
ومن ذلك قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) فالثابت بالعبارة وجوب نفقتها على الوالد فإن السياق لذلك، والثابت بالاشارة أحكام منها أن نسبة الولد إلى الاب لانه أضاف الولد إليه بحرف اللام فقال: (وعلى المولود له) فيكون دليلا على أنه هو المختص بالنسبة إليه، وهو دليل على أن للاب تأويلا في نفس الولد وماله، فإن الاضافة بحرف اللام دليل الملك كما يضاف العبد إلى سيده فيقال هذا العبد لفلان، وإلى ذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت
ومالك لابيك ولثبوت التأويل له في نفسه وماله قلنا لا يستوجب العقوبة بإتلاف نفسه ولا يحد بوطئ جاريته وإن علم حرمتها عليه، والمسائل على هذا كثيرة، وهو دليل أيضا على أن الاب لا يشاركه في النفقة على الولد غيره لانه هو المختص بالاضافة إليه والنفقة تبتني على هذه الاضافة كما وقعت الاشارة إليه في الآية، بمنزلة نفقة العبد فهي إنما تجب على سيده لا يشاركه غيره فيها، وفيه دليل أيضا على أن استئجار الام على الارضاع في حال قيام النكاح بينهما لا يجوز، لانه جعل النفقة لها عليه باعتبار عمل الارضاع بقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) فلا يستوجب بدلين باعتبار عمل واحد، وهو دليل أيضا على ما يستحق بعمل الارضاع من النفقة والكسوة لا يشترط فيه إعلام الجنس والقدر وإنما يعتبر فيه المعروف فيكون دليلا لابي حنيفة رحمه الله في جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها.
فصل: القلب والعكس قال رضي الله عنه: تفسير القلب لغة: جعل أعلى الشئ أسفله وأسفله أعلاه.
من قول القائل: قلبت الاناء إذا نكسه، أو هو: جعل بطن الشئ ظهرا والظهر بطنا.
من قول القائل: قلبت الجراب إذا جعل باطنه ظاهرا وظاهره باطنا، وقلبت الامر إذا جعله ظهرا لبطن.
وقلب العلة على هذين الوجهين.
وهو نوعان: أحدهما جعل المعلول علة والعلة معلولا، وهذا مبطل للعلة، لان العلة هي الموجبة شرعا والمعلول هو الحكم الواجب به فيكون فرعا وتبعا للعلة، وإذا جعل التبع أصلا والاصل تبعا كان ذلك دليل بطلان العلة.
وبيانه فيما قال الشافعي في الذمي إنه يجب عليه الرجم لانه من جنس من يجلد بكره مائة فيرجم ثيبه كالمسلم.
فيقلب عليه فنقول: في الاصل إنما يجلد بكره لانه يرجم ثيبه فيكون ذلك قلبا مبطلا لعلته
باعتبار أن ما جعل فرعا صار أصلا وما جعله أصلا صار تبعا.
وكذلك قوله: القراءة ركن يتكرر فرضا في الاوليين فيتكرر أيضا فرضا في الاخريين كالركوع.
وهذا النوع من القلب إنما يتأتى عند التعليل بحكم لحكم، فأما إذا كان التعليل بوصف لا يرد عليه هذا القلب، إذ الوصف لا يكون حكما شرعيا يثبت بحكم آخر.
وطريق المخلص عن هذا القلب أن لا يذكر هذا على سبيل التعليل بل على سبيل الاستدلال بأحد الحكمين على الآخر، فإن الاستدلال بحكم على حكم طريق السلف في الحوادث، روينا ذلك عن النبي عليه السلام وعن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن شرط هذا الاستدلال أن يثبت أنهما نظيران متساويان فيدل كل واحد منهما على صاحبه، هذا على ذاك في حال وذاك على هذا في حال، بمنزلة التوأم فإنه يثبت حرية الاصل لاحدهما أيهما كان بثبوته للآخر، ويثبت الرق في أيهما كان بثبوته للآخر، وذلك نحو ما يقوله علماؤنا رحمهم الله.
وبيانه فيما قال علماؤنا: إن الصوم عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحج، فلا يستقيم قلبهم علينا، لان الحج إنما يلزم بالنذر لانه يلزم بالشروع،
لانا نستدل بأحد الحكمين على الآخر بعد ثبوت المساواة بينهما من حيث إن المقصود بكل واحد منهما تحصيل عبادة زائدة هي محض حق الله تعالى، على وجه يكون المعنى فيها لازما، والرجوع عنها بعد الاداء حرام، وإبطالها بعد الصحة جناية، فبعد ثبوت المساواة بينهما يجعل هذا دليلا على ذاك تارة وذاك على هذا تارة.
وكذلك قولنا في الثيب الصغيرة من يكون موليا عليه في ماله تصرفا يكون موليا عليه في نفسه تصرفا كالبكر، وفي البكر البالغة من لا يكون موليا عليه في ماله تصرفا لا يكون موليا عليه
في نفسه تصرفا كالرجل، يكون استدلالا صحيحا بأحد الحكمين على الآخر، إذ المساواة قد تثبت بين التصرفين من حيث إن ثبوت الولاية في كل واحد منهما باعتبار حاجة المولى عليه وعجزه عن التصرف بنفسه، فلا يستقيم قلبهم إذا ذكرنا هذا على وجه الاستدلال، لان جواز الاستدلال بكل واحد منهما على الآخر يدل على قوة المشابهة والمساواة وهو المقصود بالاستدلال، بخلاف ما علل به الشافعي، فإنه لا مساواة بين الجلد والرجم، أما من حيث الذات فالرجم عقوبة غليظة تأتي على النفس والجلد لا، ومن حيث الشرط الرجم يستدعي من الشرائط ما لا يستدعي عليه الجلد كالثيوبة.
وكذلك لا مساواة بين ركن القراءة وبين الركوع، فإن الركوع فعل هو أصل في الركعة، والقراءة ذكر هو زائد، حتى إن العاجز عن الاذكار القادر على الافعال يؤدي الصلاة، والعاجز عن الافعال القادر على الاذكار لا يؤديها، ويسقط ركن القراءة بالاقتداء عندنا وعند خوف فوت الركعة بالاتفاق ولا يسقط ركن الركوع.
وكذلك لا مساواة بين الشفع الثاني والشفع الاول في القراءة، فإنه يسقط في الشفع الثاني شطر ما كان مشروعا في الشفع الاول وهو قراءة السورة والوصف المشروع فيه في الشفع الاول وهو الجهر بالقراءة، ومع انعدام المساواة لا يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر، والقلب يبطل التعليل على وجه المقايسة.
والنوع الثاني من القلب: هو جعل الظاهر باطنا بأن يجعل الوصف الذي
في المصروف إليه وهي المسكنة وجعل الواجب فعل الاطعام فيكون ذلك دليلا على أنه مشروع لاعتبار حاجة المحل، ثم هذه الحاجة تتجدد بتجدد الايام فجعلنا المسكين الواحد في عشرة أيام بمنزلة عشرة مساكين في جواز الصرف إليه، ولهذا لم نجوز
صرف جميع الكفارة إلى مسكين واحد دفعة واحدة.
فإن قيل: فقد جوزتم صرف الكسوة أيضا إلى مسكين واحد في عشرة أيام والحاجة إلى الكسوة لا تتجدد (في) كل يوم وإنما ذلك في كل ستة أشهر أو أكثر.
قلنا قد بينا أن التكفير في الكسوة يحصل بالتمليك والحاجة التي تكون باعتبار التمليك لا نهاية لها فتجعل متجددة حكما بتجدد الايام، ولهذا قال بعض مشايخنا: إذا فرق الاطعام في يوم واحد يجوز أيضا وإن أدى الكل مسكينا واحدا لان تجدد الحاجة بتجدد الوقت معلوم وحقيقتها يتعذر الوقوف عليه فيجعل باعتبار كل ساعة كأن الحاجة متجددة حكما، ولكن هذا في التمليك فأما في التمكين لا يتحقق هذا، وأكثرهم على أن في الكسوة يعتبر هذا المعنى الحكمي فأما في الطعام يعتبر بتجدد الايام لان المنصوص عليه الاطعام وحقيقته في التمكين من الطعام، ومعنى تجدد الحاجة إلى ذلك لا يتحقق إلا بتجدد الايام.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم فالثابت بالعبارة وجوب أداء صدقة الفطر في يوم العيد إلى الفقير والسياق لذلك، والثابت بالاشارة أحكام: منها أنها لا تجب إلا على الغني لان الاغناء إنما يتحقق من الغني، ومنها أن الواجب الصرف إلى المحتاج لان إغناء الغني لا يتحقق وإنما يتحقق إغناء المحتاج، ومنها أنه ينبغي أن يعجل أداءها قبل الخروج إلى المصلى ليستغني عن المسألة ويحضر المصلي فارغ القلب من قوت العيال فلا يحتاج إلى السؤال، ولهذا قال أبو يوسف لا يجوز صرفها إلا إلى فقراء المسلمين، ففي قوله (في مثل هذا اليوم) إشارة إلى ذلك، يعني أنه يوم عيد للفقراء والاغنياء جميعا وإنما يتم ذلك للفقراء إذا استغنوا عن السؤال فيه.
وقال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما: هو كذلك ولكن في هذا إشارة إلى الندب أن الاولى أن يصرفه إلى فقراء المسلمين كما أن
الاولى أن يعجل أداءها قبل الصلاة وإن كان التأخير جائزا، ومنها أن وجوب الاداء يتعلق بطلوع الفجر لان اليوم اسم للوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإنما يغنيه عن المسألة في ذلك اليوم أداء فيه، ومنها أنه يتأدى الواجب بمطلق المال لانه اعتبر الاغناء وذلك يحصل بالمال المطلق وربما يكون حصوله بالنقد أتم من حصوله بالحنطة والشعير والتمر، ومنها أن الاولى أن يصرف صدقته إلى مسكين واحد لان الاغناء بذلك يحصل وإذا فرقها على المساكين كان هذا في الاغناء دون الاول وما كان أكمل فيما هو المنصوص عليه فهو أفضل، فهذه أحكام عرفناها بإشارة النص وهو معنى جوامع الكلم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوتيت جوامع الكلم واختصر لي اختصارا هذا مثال بيان الثابت بعبارة النص وإشارته من الكتاب والسنة.
فأما الثابت بدلالة النص فهو ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطا بالرأي، لان للنظم صورة معلومة ومعنى هو المقصود به، فالالفاظ مطلوبة للمعاني وثبوت الحكم بالمعنى المطلوب باللفظ، بمنزلة الضرب له صورة معلومة ومعنى هو المطلوب به وهو الايلام، ثم ثبوت الحكم بوجود الموجب له، فكما أن في المسمى الخاص ثبوت الحكم باعتبار المعنى المعلوم بالنظم لغة فكذلك في المسمى الخاص الذي هو غير منصوص عليه يثبت الحكم بذلك المعنى ويسمى ذلك دلالة النص، فمن حيث إن الحكم غير ثابت فيه بتناول صورة النص إياه لم يكن ثابتا بعبارة النص، ومن حيث إنه ثابت بالمعنى المعلوم بالنص لغة كان دلالة النص ولم يكن قياسا، فالقياس معنى يستنبطه بالرأي مما ظهر له أثر في الشرع ليتعدى به الحكم إلى ما لا نص فيه لا استنباط باعتبار معنى النظم لغة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : الحنطة بالحنطة مثل بمثل جعلنا الغلة هي الكيل والوزن بالرأي فإن ذلك لا تتناوله صورة النظم ولا معناها لغة، ولهذا اختص العلماء بمعرفة الاستنباط بالرأي، ويشترك في معرفة
دلالة النص كل من له بصر في معنى الكلام لغة فقيها أو غير فقيه.
ومثال ما قلنا في قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما) فإن للتأفيف صورة معلومة ومعنى
لاجله ثبتت الحرمة وهو الاذى حتى إن من لا يعرف هذا المعنى من هذا اللفظ أو كان من قوم هذا في لغتهم إكرام لم تثبت الحرمة في حقه، ثم باعتبار هذا المعنى المعلوم لغة تثبت الحرمة في سائر أنواع الكلام التي فيها هذا المعنى كالشتم وغيره وفي الافعال كالضرب ونحوه، وكان ذلك معلوما بدلالة النص لا بالقياس، لان قدر ما في التأفيف من الاذى موجود فيه وزيادة.
ومثال هذا ما روي أن ماعزا زنى وهو محصن فرجم، وقد علمنا أنه ما رجم لانه ماعز بل لانه زنى في حالة الاحصان، فإذا ثبت هذا الحكم في غيره كان ثابتا بدلالة النص لا بالقياس.
وكذلك أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفارة على الاعرابي باعتبار جنايته لا لكونه أعرابيا، فمن وجدت منه مثل تلك الجناية يكون الحكم في حقه ثابتا بدلالة النص لا بالقياس، وهذا لان المعنى المعلوم بالنص لغة بمنزلة العلة المنصوص عليها شرعا على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات ثم هذا الحكم يثبت في الفأرة والحية بهذه العلة فلا يكون ثابتا بالقياس بل بدلالة النص.
وقال عليه السلام للمستحاضة: إنه دم عرق انفجر فتوضئي لكل صلاة ثم ثبت ذلك الحكم في سائر الدماء التي تسيل من العروق فيكون ثابتا بدلالة النص لا بالقياس، ولهذا جعلنا الثابت بدلالة النص كالثابت بإشارة النص وإن كان يظهر بينهما التفاوت عند المقابلة، وكل واحد منهما ضرب من البلاغة أحدهما من حيث اللفظ والآخر من حيث المعنى، ولهذا جوزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص وإن كنا لا نجوز ذلك بالقياس، فأوجبنا حد قطاع الطريق على الردء بدلالة النص، لان عبارة النص المحاربة وصورة
ذلك بمباشرة القتال ومعناها لغة قهر العدو والتخويف على وجه ينقطع به الطريق، وهذا معنى معلوم بالمحاربة لغة والردء مباشر لذلك كالمقاتل ولهذا اشتركوا في الغنيمة، فيقام الحد على الردء بدلالة النص من هذه الوجوه.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يجب الحد في اللواطة على الفاعل والمفعول به بدلالة نص الزنا، فالزنا اسم لفعل معنوي له غرض وهو اقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء بطريق حرام لا شبهة فيه وقد وجد هذا كله في اللواطة، فاقتضاء الشهوة بالمحل المشتهي وذلك بمعنى الحرارة واللين، ألا ترى أن الذين لا يعرفون الشرع لا يفصلون بينهما، والقصد منه السفاح
لان النسل لا تصور له في هذا المحل، والحرمة هنا أبلغ من الحرمة في الفعل الذي يكون في القبل فإنها حرمة لا تنكشف بحال، وإنما يبدل اسم المحل فقط فيكون الحكم ثابتا بدلالة النص لا بطريق القياس.
وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول هو قاصر في المعنى الذي وجب الحد باعتباره، فإن الحد مشروع زجرا وذلك عند دعاء الطبع إليه ودعاء الطبع إلى مباشرة هذا الفعل في القبل من الجانبين فأما في الدبر دعاء الطبع إليه من جانب الفاعل لا من جانب المفعول به، وفي باب العقوبات تعتبر صفة الكمال لما في النقصان من شبهة العدم، ثم في الزنا إفساد الفراش وإتلاف الولد حكما فإن الولد الذي يتخلق من الماء في ذلك المحل لا يعرف له والد لينفق عليه، وبالنساء عجز عن الاكتساب والانفاق ولا يوجد هذا المعنى في الدبر فإنما فيه مجرد تضييع الماء بالصب في غير محل منبت وذلك قد يكون مباحا بطريق العزل، فعرفنا أنه دون الزنا في المعنى الذي لاجله أوجب الحد ولا معتبر بتأكد الحرمة في حكم العقوبة، ألا ترى أن حرمة الدم والبول آكد من حرمة الخمر، ثم الحد يجب بشرب الخمر ولا يجب بشرب الدم والبول للتفاوت في معنى دعاء الطبع من الوجه الذي قررنا، ولهذا قلنا في قوله عليه السلام: لا قود إلا بالسيف: إن القصاص يجب إذا حصل القتل
بالرمح أو النشابة، لان لعبارة النص معنى معلوما في اللغة وذلك المعنى كامل في القتل بالرمح والنشابة، وقد عرفنا أن المراد بذكر السيف القتل به لا قبضه وإنما السيف آلة يحصل به القتل فإذا حصل بآلة أخرى مثل ذلك القتل تعلق حكم القصاص به بدلالة النص لا بالقياس.
ثم قال أبو حنيفة رحمه الله: المعنى المعلوم بذكر السيف لغة أنه ناقض للبنية بالجرح وظهور أثره في الظاهر والباطن، فلا يثبت هذا الحكم فيما لا يماثله في هذا المعنى وهو الحجر والعصا.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: المعنى المعلوم به لغة أن النفس لا تطيق احتماله ودفع أثره فيثبت الحكم بهذا المعنى في القتل بالمثقل ويكون ثابتا بدلالة النص، قالا لان القتل نقض البنية وذلك بفعله لا تحتمله البنية مع صفة السلامة وهذا المعنى في المثقل أظهر، فإن إلقاء حجر الرحى والاسطوانة على إنسان لا تحتمله البنية بنفسها والقتل بالجرح لا تحتمله البنية بواسطة السراية، وإذا كان هذا أتم في المعنى المعتبر كان ثبوت الحكم فيه
بدلالة النص، كما في الضرب مع التأفيف.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: المعتبر في باب العقوبات صفة الكمال في السبب لما في النقصان من شبهة العدم، والكمال في نقض البنية بما يكون عاملا في الظاهر والباطن جميعا، فاعتبار مجرد عدم احتمال البنية إياه مع صفة السلامة ظاهرا لتعدية الحكم غير مستقيم فيما يندرئ بالشبهات وإنما يستقيم ذلك فيما يثبت بالشبهات كالدية والكفارة، فأما ما يندرئ بالشبهات ويعتبر فيه المماثلة في الاستيفاء بالنص لا بد من اعتبار صفة الكمال فيه، ودليل النقصان حكم الذكاة فإنه يختص بما ينقض البنية ظاهرا وباطنا، ولا يعتبر فيه مجرد عدم احتمال البنية إياه، وما قاله إن الجرح وسيلة كلام لا معنى له فإننا لا نعني بفعل القتل الجناية على الجسم ولا على الروح، إذ لا تتصور بالجناية على الروح من العباد، والجسم تبع والمقصود هو النفس الذي هو عبارة عن الطبائع، فالجناية عليها إنما تتم بإراقة
الدم وذلك بعمل يكون جارحا مؤثرا في الظاهر والباطن جميعا، ولهذا كان الغرز بالابرة موجبا للقصاص لانه مسيل للدم مؤثر في الظاهر والباطن إلا أنه لا يكون موجبا الحل في الذكاة، لان المعتبر هنا تسييل جميع الدم المسفوح ليتميز به الطاهر من النجس، ولهذا اختص بقطع الحلقوم والاوداج عند التيسر، ولم يثبت حكم الحل بالنار أيضا لانها تؤثر في الظاهر حسما فلا يتميز به الطاهر من النجس بل يمتنع به من سيلان الدم.
ومن ذلك أن النبي عليه السلام لما أوجب الكفارة على الاعرابي بجنايته المعلومة بالنص لغة أوجبنا على المرأة أيضا مثل ذلك بدلالة النص لا بالقياس، واحبنا في الافطار بالاكل والشرب الكفارة ايضا بدلالة النص لا بالقياس، فإن الاعرابي سأل عن جنايته بقوله: هلكت وأهلكت.
وقد علمنا أنه لم يرد الجناية على البضع لان فعل الجماع حصل منه في محل مملوك له فلا يكون جناية لعينه، ألا ترى أنه لو كان ناسيا لصومه لم يكن ذلك منه جناية أصلا، فعرفنا أن جنايته كان على الصوم باعتبار تفويت ركنه الذي يتأدى به، وقد علم أن ركن الصوم الكف
عن اقتضاء شهوة البطن و (شهوة) الفرج ووجوب الكفارة للزجر عن الجناية على الصوم، ثم دعاء الطبع إلى اقتضاء شهوة البطن أظهر منه إلى اقتضاء شهوة الفرج ووقت الصوم وقت اقتضاء شهوة البطن عادة يعني النهر، فأما اقتضاء شهوة الفرج يكون بالليالي عادة فكان الحكم ثابتا بدلالة النص من هذا الوجه، فإن الجماع آلة لهذه الجناية كالاكل وقد بينا أنه لا معتبر بالآلة في المعنى الذي يترتب الحكم عليه وهو نظير قوله عليه السلام: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وكما يصير معتقا بالشراء يصير معتقا بقبول الهبة والصدقة فيه، لان الشراء سبب لما يتم به علة العتق وهو الملك وقبول الهبة مثل الشراء
في ذلك، ثم الجناية على الصوم بهذه الصفة تتم منها بالتمكين كما تتم به من الرجل بالايلاج، ومعنى دعاء الطبع في جانبها كهو في جانب الرجل فالكفارة تلزمها بدلالة النص لا بالقياس.
ومن ذلك قوله عليه السلام للذي أكل ناسيا في شهر رمضان: إن الله أطعمك وسقاك فتم على صومك ثم أثبتنا هذا الحكم في الذي جامع ناسيا بدلالة النص، فإن تفويت ركن الصوم حقيقة لا يختلف بالنسيان والعمد ولكن النسيان معنى معلوم لغة وهو أنه محمول عليه طبعا على وجه لا صنع له فيه ولا لاحد من العباد فكان مضافا إلى من له الحق، والجماع في حالة النسيان مثل الاكل في هذا المعنى فيثبت الحكم فيه بدلالة النص لا بالقياس، إذ المخصوص من القياس لا يقاس عليه غيره.
فإن قيل: الجماع ليس نظير الاكل من كل وجه، فإن وقت أداء الصوم وقت الاكل عادة ووقت الاسباب المفضية إلى الاكل من التصرف في الطعام وغير ذلك فيبتلى فيه بالنسيان غالبا وهو ليس بوقت الجماع عادة، والصوم أيضا يضعفه عن الجماع ولا يزيد في شهوته كما يزيد في شهوة الاكل فينبغي أن يجعل الجماع من الناسي في الصوم بمنزلة الاكل من الناسي في الصلاة لان كل واحد منهما نادر.
قلنا: نعم في الجماع هذا النوع من التقصير ولكن فيه زيادة في دعاء الطبع إليه من حيث إن الشبق قد يغلب على المرء على وجه لا يصبر عن الجماع وعند غلبة الشبق يذهب من قلبه كل شئ سوى ذلك المقصود ولا يوجد مثل هذا الشبق في الاكل فتكون هذه الزيادة بمقابلة ذلك القصور حتى تتحقق المساواة بينهما، ولكن لا تعتبر هذه الزيادة عند ذكر الصوم في حق الكفارة، لان غلبة الشبق بهذه الصفة تنعدم بإباحة الجماع ليلا، ولانه لا يكون إلا نادرا وصفة الكمال لا تبتنى على ما هو نادر
وإنما تبتنى على ما هو المعتاد، وإنما طريق القياس في هذا ما سلكه الشافعي رحمه الله حيث جعل المكره والخاطئ بمنزلة الناسي باعتبار وصف العذر، فإن الكره والخطأ غير النسيان صورة ومعنى، فالحكم الثابت بالنسيان لا يكون ثابتا بالخطأ والكره بدلالة النص بل يكون بطريق القياس، وهو قياس فاسد، فإن الكره مضاف إلى غير من له الحق وهو المكره، والخطأ مضاف إلى المخطئ أيضا وهو مما يتأتى عنه التحرز في الجملة فلم يكن في معنى ما لا صنع للعباد فيه أصلا، ألا ترى أن المريض يصلي قاعدا ثم لا تلزمه الاعادة إذا برأ بخلاف المقيد.
ومن ذلك أن الله تعالى لما أوجب القضاء على المفطر في رمضان بعذر، وهو المريض والمسافر، أوجبنا على المفطر بغير عذر بدلالة النص لا بالقياس، فإن في الموضعين ينعدم أداء الصوم الواجب في الوقت والمرض والسفر عذر في الاسقاط لا في الايجاب، فعرفنا أن وجوب القضاء عليهما لانعدام الاداء في الوقت بالفطر لغة وقد وجد هذا المعنى بعينه إذا أفطر من غير عذر فيلزمه القضاء بدلالة النص.
ثم قال الشافعي رحمه الله: بهذا الطريق أوجبت الكفارة في قتل العمد، لان النص جاء بإيجاب الكفارة في قتل الخطأ ولكن الخطأ عذر مسقط، فعرفنا أن وجوب الكفارة باعتبار أصل القتل دون صفة الخطأ وذلك موجود في العمد وزيادة فتجب الكفارة في العمد بدلالة النص، وبهذا الطريق أوجبت الكفارة في الغموس، لان في المعقود على أمر في المستقبل وجبت الكفارة باعتبار جنايته، لما في الاقدام على الحنث من هتك حرمة اسم الله تعالى وذلك موجود في الغموس وزيادة، فإنها محظورة لاجل الاستشهاد بالله تعالى كاذبا، وهذا هو صفة الحظر في المعقودة على أمر في المستقبل بعد الحنث.
ولكنا نقول: هذا الاستدلال
فاسد، لان الواجب بالنص الكفارة وهي اسم لعبادة فيها معنى العقوبة تبعا من حيث
إنها أوجبت جزاء ولكنها تتأدى بفعل هو عبادة والمقصود بها نيل الثواب ليكون مكفرا للذنب وإنما يحصل ذلك بما هو عبادة كما قال تعالى: (إن الحسنات يذهبن السيئات) فيستدعي سببا مترددا بين الحظر والاباحة، لان العقوبات المحضة سببها محظور محض والعبادات المحضة سببها ما لا حظر فيه، فالمتردد يستدعي سببا مترددا وذلك في قتل الخطأ، فإنه من حيث الصورة رمى إلى الصيد أو إلى الكافر وهو المباح، وباعتبار المحل يكون محظورا لانه أصاب آدميا محترما، فأما العمد فهو محظور محض فلا يصلح سببا للكفارة، وكذلك المعقودة على أمر في المستقبل فيها تردد، فإن تعظيم المقسم به في الابتداء وذلك مندوب إليه ولهذا شرعت في بيعة نصرة الحق وفيها معنى الحظر أيضا، قال تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) وقال تعالى: (واحفظوا أيمانكم) والمراد الحفظ بالامتناع عن اليمين فلكونها دائرة بين الحظر والاباحة تصلح سببا للكفارة، فأما الغموس محظور محض لان الكذب بدون الاستشهاد بالله تعالى حرام ليس فيه شبهة الاباحة فمع الاستشهاد بالله تعالى أولى، فكان الغموس باعتبار هذا المعنى كالزنا والردة فلا يصلح سببا لوجوب الكفارة.
ولا يدخل عليه القتل بالمثقل على قول أبي حنيفة فإنه موجب لكفارة وإن كان محظورا محضا لان المثقل ليس بآلة للقتل بأصل الخلقة وإنما هو آلة للتأديب، ألا ترى أن إجراءه للتأديب به والمحل قابل للتأديب مباح فلتمكن الشبهة من حيث الآلة يصير الفعل في معنى الدائر ولهذا لم يجعله موجبا للعقوبة فجعله موجبا للكفارة، ولا يدخل على هذا قتل الحربي المستأمن (عمدا) فإنه غير موجب للكفارة وإن لم تمكن فيه شبهة حتى لم يكن موجبا للقصاص، لان امتناع وجوب القصاص هناك لانعدام المماثلة بين المحلين لا لشبهة ولهذا يجب القصاص على المستأمن بقتل المستأمن.
نص عليه في السير الكبير.
وإن كان امتناع وجوب القصاص لاجل الشبهة فتلك الشبهة في المحل لا في الفعل وفي القصاص مقابلة المحل بالمحل ولهذا لا تجب الدية مع
وجوب القصاص، فأما الكفارة جزاء الفعل ولا شبهة في الفعل هناك بل هو محظور
محض فلم يكن موجبا للكفارة، فأما في المثقل الشبهة في الفعل باعتبار أن الآلة ليست بآلة القتل والفعل لا يتأتى بدون الآلة فاعتبرنا هذه الشبهة في القصاص والكفارة جميعا.
وقال الشافعي رحمه الله أيضا: يجب سجود السهو على من زاد أو نقص في صلاته عمدا لان وجوب السجود عليه عند السهو باعتبار تمكن النقصان في صلاته وذلك موجود في العمد وزيادة فيثبت الحكم فيه بدلالة النص.
وقلنا: هذا الاستدلال فاسد لان السبب الموجب بالنص شرعا هو السهو على ما قال عليه الصلاة والسلام: لكل سهو سجدتان بعد السلام والسهو ينعدم إذا كان عامدا.
فهذا هو المثال في بيان الثابت بدلالة النص.
والنوع الرابع وهو المقتضى، وهو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيدا أو موجبا للحكم وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم فكان المقتضى مع الحكم مضافين إلى النص ثابتين به الحكم بواسطة المقتضى بمنزلة شراء القريب يثبت به الملك والعتق على أن يكونا مضافين إلى الشراء العتق بواسطة الملك، فعرفنا أن الثابت بطريق الاقتضاء بمنزلة الثابت بدلالة النص لا بمنزلة الثابت بطريق القياس، إلا أن عند المعارضة الثابت بدلالة النص أقوى، لان النص يوجبه باعتبار المعنى لغة والمقتضى ليس من موجباته لغة وإنما ثبت شرعا للحاجة إلى إثبات الحكم به ولا عموم للمقتضى عندنا.
وقال الشافعي: للمقتضى عموم لان المقتضى بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به حتى كان الحكم الثابت به كالثابت بالنص لا بالقياس فكذلك في إثبات صفة العموم فيه فيجعل كالمنصوص.
ولكنا نقول: ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة حتى إذا كان المنصوص مفيدا للحكم بدون المقتضى لا يثبت المقتضى لغة ولا شرعا والثابت بالحاجة يتقدر بقدرها ولا حاجة إلى
إثبات صفة العموم للمقتضى فإن الكلام مفيد بدونه، وهو نظير تناول الميتة لما أبيح للحاجة تتقدر بقدرها وهو سد الرمق وفيما وراء ذلك من الحمل والتمول والتناول إلى الشبع لا يثبت حكم الاباحة فيه، بخلاف المنصوص فإنه عامل بنفسه فيكون بمنزلة حل الذكية يظهر في حكم التناول وغيره مطلقا، يوضحه أن المقتضى تبع للمقتضي
فإنه شرطه ليكون مفيدا وشرط الشئ يكون تبعه ولهذا يكون ثبوته بشرائط المنصوص فلو جعل هو كالمنصوص خرج من أن يكون تبعا، والعموم حكم صيغة النص خاصة فلا يجوز إثباته في المقتضى.
وعلى هذا الاصل قلنا إذا قال لغيره أعتق عبدك عني على ألف درهم فأعتقه وقع العتق عن الآمر وعليه الالف، لان الامر بالاعتاق عنه يقتضي تمليك العين منه بالبيع ليتحقق الاعتاق عنه وهذا المقتضى يثبت متقدما ويكون بمنزلة الشرط لانه وصف في المحل والمحل للتصرف كالشرط فكذا ما يكون وصفا للمحل، وإنما يثبت بشرط العتق لا بشرط البيع مقصودا حتى يسقط اعتبار القبول فيه، ولو كان الآمر ممن لا يملك الاعتاق لم يثبت البيع بهذا الكلام، ولو صرح المأمور بالبيع بأن قال بعته منك بألف درهم وأعتقته لم يجز عن الآمر، وبهذا تبين أن المقتضى ليس كالمنصوص عليه فيما وراء موضع الحاجة.
وعلى هذا قال أبو يوسف إذا قال أعتق عبدك عني بغير شئ فأعتقه يقع العتق عن الآمر، لان الملك بطريق الهبة يثبت هنا بمقتضى العتق فيثبت على شرائط العتق ويسقط اعتبار شرطه مقصودا وهو القبض كما يسقط اعتبار القبول في البيع بل أولى، لان القبول ركن في البيع والقبض شرط في الهبة فلما سقط اعتبار ما هو الركن لكونه ثابتا بمقتضى العتق فلان يسقط اعتبار ما هو شرط أولى، ولهذا لو قال أعتق عبدك عني على ألف (درهم) ورطل من خمر يقع العتق عن الآمر، ولو أكره المأمور على أن يعتق عبده عنه بألف درهم يقع العتق عن الآمر، وبيع
المكره فاسد والقبض شرط لوقوع الملك في البيع الفاسد ثم سقط اعتباره إذا كان بمقتضى العتق.
وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا المقتضى تبع للمقتضي والقبض فعل ليس من جنس القول ولا هو دونه حتى يمكن إثباته تبعا له وبدون القبض الملك لا يحصل بالهبة فلا يمكن تنفيذ العتق عن الآمر، ولا وجه لجعل العبد قابضا نفسه للآمر لانه لا يسلم له بالعتق شئ من ملك المولى وإنما يبطل ملك المولى ويتلاشى بالاعتاق، ولا وجه لاسقاط القبض هنا بطريق الاقتضاء لان العمل بالمقتضى شرعي
فإنما يعمل في إسقاط ما يحتمل السقوط دون ما لا يحتمل وشرط القبض لوقوع الملك في الهبة لا يحتمل السقوط بحال بخلاف القبول في البيع فقد يحتمل السقوط، ألا ترى أن الايجاب والقبول جميعا يحتمل السقوط حتى ينعقد البيع بالتعاطي من غير قول، فلان يحتمل مجرد القبول السقوط كان أولى.
ولو قال بعت منك هذا الثوب بعشرة فاقطعه فقطعه ولم يقل شيئا كان البيع بينهما تاما، والفاسد من البيع معتبر بالجائز في الحكم لان الفاسد لا يمكن أن يجعل أصلا يتعرف حكمه من نفسه، وإذا كان ما ثبت الملك به في البيع الجائز يحتمل السقوط إذا كان ضمنا للعتق فكذلك ما يثبت به الملك في البيع الفاسد.
وبيان ما ذكرنا من الخلاف بيننا وبين الشافعي فيما إذا قال إن أكلت فعبدي حر ونوى طعاما دون طعام، عنده تعمل نيته لان الاكل يقتضي مأكولا وذلك كالمنصوص عليه فكأنه قال إن أكلت طعاما، ولما كان للمقتضي عموم على قوله عمل فيه نيته التخصيص، وعندنا لا تعمل لانه لا عموم للمقتضى ونية التخصيص فيما لا عموم له لغو بخلاف ما لو قال إن أكلت طعاما، وعلى هذا لو قال إن شربت أو قال إن لبست أو قال إن ركبت.
وعلى هذا قلنا لو قال إن اغتسلت الليلة ونوى الاغتسال من الجنابة لم تعمل نيته، بخلاف ما لو قال إن اغتسلت غسلا فإن هناك نيته تعمل فيما بينه وبين الله تعالى.
وكذلك لو قال: إن اغتسل الليلة في هذه الدار
وقال عنيت فلانا لم تعمل نيته لان الفاعل ليس في لفظه وإنما يثبت بطريق الاقتضاء، بخلاف ما لو قال إن اغتسل أحد في هذه الدار الليلة.
وعلى هذا لو قال لامرأته اعتدي ونوى الطلاق فإن وقوع الطلاق بطريق الاقتضاء لانها لا تعتد قبل تقدم الطلاق فيصير كأنه قال طلقتك فاعتدي ولكن ثبوته بطريق الاقتضاء، ولهذا كان الواقع رجعيا ولا تعمل نيته الثلاث فيه، وبعد البينونة والشروع في العدة يقع الطلاق بهذا اللفظ.
وربما يستدل الشافعي رحمه الله بهذا في أن المقتضى كالمنصوص عليه، وهو خارج على ما ذكرنا فإنا نجعله كالمنصوص عليه بقدر الحاجة وهو أن يصير المنصوص مفيدا موجبا للحكم فأما فيما وراء ذلك فلا.
قال رضي الله عنه: وقد رأيت لبعض من صنف في هذا الباب أنه ألحق المحذوف بالمقتضى وسوى بينهما، فخرج على هذا الاصل قوله تعالى: (واسأل القرية) وقال المراد الاهل، يثبت ذلك بمقتضى الكلام لان السؤال للتبيين فإنما ينصرف إلى من يتحقق منه البيان ليكون مفيدا دون من لا يتحقق منه، وقال عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولم يرد به العين لانه يتحقق مع هذه الاعذار فلو حمل عليه كان كذبا ولا إشكال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن ذلك، فعرفنا بمقتضى الكلام أن المراد الحكم.
ثم حمله الشافعي على الحكم في الدنيا والآخرة قولا بالعموم في المقتضى وجعل ذلك كالمنصوص عليه ولو قال رفع عن أمتي حكم الخطأ كان ذلك عاما، ولهذا الاصل قال لا يقع طلاق الخاطئ والمكره ولا يفسد الصوم بالاكل مكرها.
وقلنا لا عموم للمقتضي وحكم الآخرة وهو الاثم مراد بالاجماع وبه ترتفع الحاجة ويصير الكلام مفيدا فيبقى معتبرا في حكم الدنيا.
كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الاعمال بالنيات ليس المراد عين العمل فإن ذلك متحقق بدون النية وإنما المراد الحكم ثبت ذلك بمقتضى الكلام.
فقال الشافعي يعم ذلك حكم الدنيا والآخرة فيما يستدعي القصد والعزيمة من الاعمال قولا بعموم المقتضى.
وقلنا المراد حكم الآخرة وهو أن ثواب العمل بحسب النية، لان ثبوته بطريق الاقتضاء ولا عموم للمقتضى.
وعندي أن هذا سهو من قائله فإن المحذوف غير المقتضى لان من عادة أهل اللسان حذف بعض الكلام للاختصار إذا كان فيما بقي منه دليل على المحذوف، ثم ثبوت هذا المحذوف من هذا الوجه يكون لغة وثبوت المقتضى يكون شرعا لا لغة، وعلامة الفرق بينهما أن المقتضى تبع يصح باعتباره المقتضي إذا صار كالمصرح به والمحذوف ليس بتبع بل عند التصريح به ينتقل الحكم إليه لا أن يثبت ما هو المنصوص، ولا شك أن ما ينقل غير ما يصحح المنصوص.
وبيان هذا أن في قوله أعتق عبدك عني محذوفا ويثبت التمليك بطريق الاقتضاء ليصح المنصوص، وفي قوله: (واسأل القرية) الاهل محذوف للاختصار
فإن فيما بقي من الكلام دليل عليه وعند التصريح بهذا المحذوف يتحول السؤال عن القرية إلى الاهل لا أن يتحقق به المنصوص.
وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ فإن عند التصريح بالحكم يتحول الرفع إلى الحكم لا إلى ما وقع التنصيص عليه مع المحذوف.
وكذلك قوله عليه السلام: الاعمال بالنيات وإنما لم يثبت العموم هنا لان المحذوف بمنزلة المشترك في أنه يحتمل كل واحد من الامرين على الانفراد ولا عموم للمشترك فأما أن يجعل المحذوف ثابتا بمقتضى الكلام فلا.
ويتبين من هذا أن ما كان محذوفا ليس بطريق الاقتضاء فإنه بمنزلة الثابت لغة فإن كان بحيث يحتمل العموم يثبت فيه صفة العموم.
وعلى هذا ما إذا قال لامرأته أنت طالق أو طلقتك ونوى ثلاثا فإن على قول الشافعي تعمل نيته، لان قوله طالق يقتضي طلاقا وذلك كالمنصوص عليه فتعمل نيته الثلاث فيه قولا بالعموم في المقتضى.
وقلنا نحن إن قوله طالق نعت فرد ونعت الفرد لا يحتمل العدد والنية
إنما تعمل إذا كان المنوي من محتملات اللفظ ولا يمكن إعمال نية العدد باعتبار المقتضى لانه لا عموم للمقتضي، ولان المقتضى لا يجعل كالمصرح به في أصل الطلاق فكيف يجعل كالمصرح به في عدد الطلاق ؟ وبيانه أنه إذا قال لامرأته زوري أباك أو حجي ونوى به الطلاق لم تعمل نيته ومعلوم أن ما صرح به يقتضي ذهابا لا محالة، ثم لم يجعل بمنزلة قوله اذهبي حتى تعمل نيته الطلاق فيه، يقرره أن قوله طالق نعت للمرأة فإنما يعتبر فيه من المقتضى ما يكون قائما بالموصوف والطلاق من هذا اللفظ مقتضى هو ثابت بالواصف شرعا فإنه لا يكون صادقا في هذا الوصف بدون طلاق يقع عليها فيجعل موقعا ليتحقق هذا الوصف منه صدقا، ومثل هذا المقتضى لا يكون كالمصرح به شرعا بمنزلة الحال الذي هو قائم بالمخاطب وهو بعده عن موضع الحج وعن الزيارة فإن اقتضاء الذهاب لما كان لذلك المعنى لا لما هو قائم بالمنصوص لا يجعل كالمصرح به، بخلاف قوله أنت بائن فإن ذلك نعت فرد نصا حتى لا يسع نية العدد فيه لو نوى اثنتين ولكن البينونة تتصل بالمحل في الحال، وهي نوعان: قاطعة للملك، وقاطعة للحل
الذي هو وصف المحل، فنية الثلاث إنما تميز أحد نوعي ما تناوله نص كلامه فأما الطلاق لا يتصل بالمحل موجبا حكمه في الحال بل حكم انقطاع الملك به يتأخر إلى انقضاء العدة وحكم انقطاع الحل به يتأخر إلى تمام العدة وإنما يوصف المحل للحال به لانعقاد العلة (فيه) موجبا للحكم في أوانه وانعقاد العلة لا يتنوع فلم يكن المنوي من محتملات لفظه أصلا.
وعلى هذا قوله طلقتك فإن صيغة الخبر عن فعل ماض بمنزلة قوله ضربتك، فالمصدر القائم بهذه الصيغة يكون ماضيا أيضا فلا يسع فيه معنى العموم بوجه، بخلاف قوله طلقي نفسك فإن صيغته أمر بفعل في المستقبل لطلب ذلك الفعل منها، فالمصدر القائم بهذه الصيغة يكون مستقبلا أيضا وذلك الطلاق فيكون بمنزلة غيره من أسماء الاجناس في احتمال العموم والخصوص فبدون النية يثبت به أخص
الخصوص على احتمال الكل، فإذا نوى الثلاث عملت نيته لانه من محتملات كلامه، وإذا نوى اثنتين لم تعمل لانه لا احتمال للعدد في صيغة كلامه، وعلى هذا لو قال إن خرجت ونوى الخروج إلى مكان بعينه لم تعمل نيته ولو نوى السفر تعمل نيته، لان السفر نوع من أنواع الخروج وهو ثابت باعتبار صيغة كلامه، ألا ترى أن الخروج لغير السفر بخلاف الخروج للسفر في الحكم، فأما المكان فليس من صيغة كلامه في شئ وإن كان الخروج يكون إلى مكان لا محالة فلم تعمل نية التخصيص فيه لما لم يكن من مقتضى صيغة الكلام بخلاف الاول.
وكذلك لو قال إن ساكنت فلانا ونوى المساكنة في مكان بعينه لم تعمل نيته أصلا، ولو نوى المساكنة في بيت واحد تعمل نيته باعتبار أنه نوى أتم ما يكون من المساكنة فإن أعم ما يكون من المساكنة في بلدة، والمطلق من المساكنة في عرف الناس في دار واحدة، وأتم ما يكون من المساكنة في بيت واحد، فهذه النية ترجع إلى بيان نوع المساكنة الثابتة بصيغة كلامه بخلاف تعين المكان.
فإن قيل: أليس أنه لو قال لولد له أم معروفة وهو في يده: هذا ابني ثم جاءت أمه بعد موت المدعي فصدقته وادعت ميراثها منه بالنكاح فإنه يقضى لها بالميراث،
ومعلوم أن النكاح بينهما بمقتضى دعوى النسب ثم يجعل كالتصريح به حتى يثبت النكاح صحيحا ويجعل قائما إلى موت الزوج فيكون لها الميراث، فلو كان ثبوت المقتضى باعتبار الحاجة فقط لما ثبتت هذه الاحكام لانعدام الحاجة فيها ؟ قلنا: ثبوت النكاح هنا بدلالة النص لا بمقتضاه، فإن الولد اسم مشترك إذ لا يتصور ولد فينا إلا بوالد ووالدة، فالتنصيص على الولد يكون تنصيصا على الوالد والوالدة دلالة بمنزلة التنصيص على الاخ يكون كالتنصيص على أخيه إذ الاخوة لا تتصور إلا بين شخصين وقد بينا أن الثابت بدلالة النص يكون ثابتا بمعنى النص لغة لا أن يكون ثابتا بطريق
الاقتضاء مع أن اقتضاء النكاح هنا كاقتضاء الملك في قوله أعتق عبدك عني على ألف (درهم) وبعدما ثبت العقد بطريق الاقتضاء يكون باقيا لا باعتبار دليل يبقى بل لانعدام دليل المزيل، فعرفنا أنه منته بينهما بالوفاة وانتهاء النكاح بالموت سبب لاستحقاق الميراث.
وبعدما بينا هذه الحدود نقول: الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص لانه لا عموم له والتخصيص فيما فيه احتمال العموم، والثابت بدلالة النص لا يحتمل التخصيص أيضا لان التخصيص بيان أن أصل الكلام غير متناول له وقد بينا أن الحكم الثابت بالدلالة ثابت بمعنى النص لغة، وبعدما كان معنى النص متناولا له لغة لا يبقى احتمال كونه غير متناول له وإنما يحتمل إخراجه من أن يكون موبجا للحكم فيه بدليل يعترض وذلك يكون نسخا لا تخصيصا.
وأما الثابت بإشارة النص فعند بعض مشايخنا رحمهم الله لا يحتمل الخصوص أيضا لان معنى العموم فيما يكون سياق الكلام لاجله، فأما ما تقع الاشارة إليه من غير أن يكون سياق الكلام له فهو زيادة على المطلوب بالنص ومثل هذا لا يسع فيه معنى العموم حتى يكون محتملا للتخصيص.
قال رضي الله عنه: والاصح عندي أنه يحتمل ذلك، لان الثابت بالاشارة كالثابت بالعبارة من حيث إنه ثابت بصيغة الكلام، والعموم باعتبار الصيغة، فكما أن الثابت بعبارة النص يحتمل التخصيص فكذلك الثابت بإشارته.
فصل وقد عمل قوم في النصوص بوجوه هي فاسدة عندنا.
فمنها ما قال بعضهم إن التنصيص على الشئ باسم العلم يوجب التخصيص وقطع الشركة بين المنصوص وغيره من جنسه في الحكم لانه لو لم يوجب ذلك لم يظهر للتخصيص فائدة وحاشا أن يكون شئ من كلام صاحب الشرع غير مفيد، وأيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم
الماء من الماء فالانصار فهموا التخصيص من ذلك حتى استدلوا به على نفي وجوب الاغتسال بالاكسال وهم كانوا أهل اللسان.
وهذا فاسد عندنا بالكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال: (منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) ولا يدل ذلك على إباحة الظلم في غير الاشهر الحرم، وقال تعالى: (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) ثم لا يدل ذلك على تخصيص الاستثناء بالغد دون غيره من الاوقات في المستقبل.
وقال صلى الله عليه وسلم : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة ثم لا يدل ذلك على التخصيص بالجنابة دون غيرها من أسباب الاغتسال، والامثلة لهذا تكثر.
ثم إن عنوا بقولهم إن التخصيص يدل على قطع المشاركة وهو أن الحكم يثبت بالنص في المنصوص خاصة فأحد لا يخالفهم في هذا، فإن عندنا فيما هو من جنس المنصوص الحكم يثبت بعلة النص لا بعينه، وإن عنوا أن هذا التخصيص يوجب نفي الحكم في غير المنصوص فهو باطل، لانه غير متناول له أصلا فكيف يوجب نفيا أو إثباتا للحكم فيما لم يتناوله ؟ ثم سياق النص لايجاب الحكم ونفي الحكم ضده فلا يجوز أن يكون من واجبات نص الايجاب، ولان المذهب عند فقهاء الامصار جواز تعليل النصوص لتعدية الحكم بها إلى الفروع فلو كان التخصيص موجبا نفي الحكم في غير المنصوص لكان التعليل باطلا لانه يكون ذلك قياسا في مقابلة النص، ومن لا يجوز
العمل بالقياس فإنما لا يجوزه لاحتمال فيه بين أن يكون صوابا أو خطأ لا لنص يمنع منه، بمنزلة العمل بخبر الفاسق فإنه لا يعمل بخبره لضعف في سنده لا لنص في خبره مانع من العمل به، والانصار إنما استدلوا بلام التعريف التي هي مستغرقة للجنس أو المعهود في قوله عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء ونحن نقول به في الحكم الثابت لعين الماء، وفائدة التخصيص عندنا أن يتأمل المستنبطون في علة النص
فيثبتون الحكم بها في غير المنصوص عليه من المواضع لينالوا به درجة المستنبطين وثوابهم وهذا لا يحصل إذا ورد النص عاما متناولا للجنس.
ويحكى عن الثلجي رحمه الله أنه كان يقول هذا إذا لم يكن المنصوص عليه باسم العلم محصورا بعدد نصا نحو خبر الربا فإن كان محصورا بعدد فذلك يدل على نفي الحكم فيما سواها، لان في إثبات الحكم فيما سواها إبطال العدد المنصوص وذلك لا يجوز فبهذه الواسطة يكون موجبا للنفي.
واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وبقوله: أحلت لنا ميتتان ودمان فإن ذلك يدل على نفي الحكم فيما عدا المذكور.
والصحيح أن التنصيص لا يدل على ذلك في شئ من المواضع لما بينا من المعاني.
ثم ذكر العدد لبيان الحكم بالنص ثابت في العدد المذكور فقط وقد بينا أن في غير المذكور إنما يثبت الحكم بعلة النص لا بالنص فلا يوجب ذلك إبطال العدد المنصوص.
ومنها ما قاله الشافعي رحمه الله إن التنصيص على وصف في المسمى لايجاب الحكم يوجب نفي ذلك الحكم عند عدم ذلك الوصف بمنزلة ما لو نص على نفي الحكم عند عدم الوصف.
وعندنا النص موجب للحكم عند وجود ذلك الوصف ولا يوجب نفي ذلك الحكم عند انعدامه أصلا.
وبيان هذا في قوله تعالى: (من فتياتكم المؤمنات) فإن عنده إباحة نكاح الامة (لما كان مقيدا بصفة الايمان بالنص أوجب النفي بدون هذا الوصف فلا يجوز نكاح الامة الكتابية، وعندنا لا يوجب ذلك ولهذا جوزنا نكاح الامة) الكتابية، وقال تعالى: (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) فقال الشافعي رحمه الله: لما ورد حرمة الربيبة بسبب الدخول بامرأة مقيدة بوصف وهي أن تكون من نسائه أوجب ذلك نفي الحرمة عند عدم
ذلك الوصف فلا تثبت الحرمة بالزنا.
وعندنا لا يوجب النص نفي الحكم عند انعدام الوصف فتثبت الحرمة بالزنا، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم
فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد من المسلمين فعلى مذهبه أوجب هذا النص نفي الحكم عند عدم الوصف فلا تجب الصدقة عن العبد الكافر.
وعندنا لا يوجب ذلك ولكن النص المختتم بهذا الوصف لا يتناول الكفار، والنص المطلق وهو قوله: أدوا عن كل حر وعبد يتناولهم لانه غير مختتم بهذا التقييد فيجب الاداء عن العبد الكافر بذلك النص، وهو بمنزلة من يقول لغيره أعتق عبيدي ثم يقول أعتق البيض من عبيدي فلا يوجب ذلك النهي عن إعتاق غير البيض بعدما كان ثابتا باللفظ المطلق.
واستدل الشافعي رحمه الله لاثبات مذهبه عليه السلام: في خمس من الابل السائمة شاة فإن ذلك يوجب نفي الزكاة في غير السائمة فكأنه قال ولا زكاة في غير السائمة إذ لو لم يجعل كذلك فلا بد من إيجاب الزكاة في العوامل بخبر المطلق وهو قوله عليه السلام: في خمس من الابل شاة وبالاجماع بيننا وبينكم لا تجب الزكاة في غير السائمة، ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن أفهمنا ذلك إباحة ربح ما قد ضمن كأنه نص عليه، ولان النص لما أوجب الحكم في المسمى المشتمل على أوصاف مقيدا بوصف من تلك الاوصاف صار ذلك الوصف بمنزلة الشرط لايجاب الحكم على معنى أنه لا يثبت الحكم بالنص بعد وجود المسمى ما لم يوجد ذلك الوصف، فلولا ذكر الوصف لكان الحكم ثابتا قبل وجوده وهذا أمارة الشرط، فإن قوله لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار لا يكون موجبا وقوع الطلاق ما لم تدخل، وبدون هذا الشرط كان موجبا للطلاق قبل الدخول.
وقد يكون الوصف بمنزلة الشرط حتى لو قال لها إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق كان الركوب شرطا وإن كان مذكورا على سبيل الوصف لها.
قال وقد ثبت من أصلي أن التقييد بالشرط يفهمنا نفي الحكم عند عدم الشرط
فكذلك التقييد بالوصف، وهذا بخلاف الاسم فإنه مذكور للتعريف لا لتعليق
الحكم به (فأما الوصف الذي هو ذكر للحال وهو معنوي يصلح أن يكون لتعليق الحكم به) فيكون موجبا نفي الحكم عند عدمه دلالة، ولان بالاسم يثبت الحكم ابتداء كما ثبت بالعلة بخلاف الوصف الذي هو في معنى الشرط.
وسنقرر هذا الفرق في الفصل الثاني.
واستدل علماؤنا بقوله تعالى: (وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك) ثم التقييد بهذا الوصف لا يوجب نفي الحل في اللاتي لم يهاجرن معه بالاتفاق، وقال تعالى: (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا) ثم التقييد بهذا الوصف لا يفيد إباحة الاكل بدون هذا الوصف، وقال تعالى: (إنما أنت منذر من يخشاها) .
(إنما تنذر من اتبع الذكر) وهو نذير للبشر، فعرفنا أن التقييد بالوصف لا يفهمنا نفي المنصوص عليه عند عدم ذلك الوصف، ثم أكثر ما فيه أن الوصف المؤثر بمنزلة العلة للحكم ولا خلاف أن الحكم يثبت بالعلة إذا وجدت فإن العلة لا توجب نفي الحكم عند انعدامها فكذلك الوصف المذكور في النص يوجب ثبوت الحكم عند وجوده ولا يوجب نفي الحكم عند عدمه، ولهذا جعلنا الوصف المؤثر إذا كان منصوصا عليه بمنزلة العلة للحكم الثابت بالنص فقلنا صفة السوم بمنزلة العلة لايجاب الزكاة في خمس من الابل، ولهذا يضاف الزكاة إليها فيقال زكاة السائمة، والواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة بمنزلة من يقول لغيره أعتق عبدي الصالح أو طلق امرأتي البذيئة، فإن ذكر هذا الوصف دليل على أنه هو المؤثر للحكم.
وبهذا يتبين أن الوصف ليس في معنى الشرط كما زعم، وقوله إن دخلت راكبة إنما جعلنا الركوب شرطا لكونه معطوفا على الشرط فإن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه، فأما الوصف المقرون بالاسم يكون بمنزلته والاسم ليس في معنى الشرط لاثبات الحكم فكذلك الوصف المقرون به.
ولو كان شرطا فعندنا تعليق الحكم بالشرط يوجب وجود الحكم
عند وجود الشرط ولا يوجب النفي عند عدم الشرط بل ذلك باق على ما كان قبل التعليق على ما نبينه، وإنما لا نوجب الزكاة في الحوامل باعتبار نص آخر وهو قوله عليه السلام: لا زكاة في العوامل والحوامل أو باعتبار أن صفة السوم صار بمنزلة العلة في حكم الزكاة على ما قررنا.
وعلى هذا قال زفر رحمه الله فيمن له أمة ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فقال: الاكبر ابني يثبت نسب الآخرين منه، لان التنصيص على الدعوة مقيدا بالاكبر لا موجب له في نفي نسب الآخرين، وقد تبين ثبوت نسب الاكبر منه أنها كانت أم ولد له من ذلك الوقت وأم الولد فراش للمولى يثبت نسب ولدها منه بغير دعوة.
وعندنا لا يثبت نسب الآخرين منه لا للتقييد بالوصف فإنه لو أشار إلى الاكبر وقال هذا ابني لا يثبت نسب الآخرين منه أيضا، ومعلوم أن التنصيص بالاسم لا يوجب نفي الحكم في غير المسمى بذلك الاسم ولكن إنما لا يثبت نسبهما منه لان السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة دليل النفي ويفترض على المرأة دعوة النسب فيما هو مخلوق من مائه، لانه كما لا يحل له أن يدعي نسب (ما هو غير مخلوق من مائه لا يحل له أن ينفي نسب) المخلوق من مائه، وقبل الدعوة النسب يثبت منه على سبيل الاحتمال حتى يملك نفيه وإنما يصير مقطوعا به على وجه لا يملك نفيه بالدعوة فكان ذلك فرضا عليه.
وإذا تقرر بهذا تحقق الحاجة إلى البيان كان سكوته عن دعوة نسب الآخرين دليل النفي لا تخصيصه الاكبر بالدعوة فلهذا لا يثبت نسبهما منه.
وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قال شهود الوارث لا نعلم له وارثا غيره في أرض كذا إن الشهادة تقبل، لان هذه الزيادة لا توجب عليهم توارث آخر في غير ذلك الموضع، فكأنهم سكتوا عن ذكر هذه الزيادة وقالوا لا نعلم له وارثا غيره.
وأبو يوسف ومحمد قالا: لا تقبل هذه الشهادة لا لانها توجب ذلك ولكن لتمكن التهمة فإنه يحتمل أنهما خصا ذلك المكان للتحرز عن الكذب وعلمهما
بوارث آخر له في غير ذلك المكان ولكن الشهادة ترد بالتهمة، فأما الحكم
لا يثبت نفيا ولا إيجابا بالتهمة بل بالحجة المعلومة.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: كما تحتمل هذه الزيادة ما قالا تحتمل المبالغة في التحرز عن الكذب باعتبار أنهما تفحصا في ذلك الموضع دون سائر المواضع، ويحتمل تحقيق المبالغة في نفي وارث آخر أي لا نعلم له وارثا آخر في موضع كذا مع أنه مولده ومنشؤه فأحرى أن لا يكون له وارث آخر في موضع آخر، وبمثل هذا المحتمل لا تتمكن التهمة ولا يمنع العمل بشهادتهما.
ومنها أن الحكم متى تعلق بشرط بالنص فعند الشافعي رحمه الله ذلك النص يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط كما يوجب وجود الحكم عند وجود الشرط، وعندنا لا يوجب النص ذلك بل يوجب ثبوت الحكم عند وجود الشرط فأما انعدام الحكم عند عدم الشرط فهو باق على ما كان قبل التعليق.
وبيان هذا في قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات) الآية، فإن النص لما ورد بحل نكاح الامة معلقا بشرط عدم طول الحرة جعل الشافعي ذلك كالتنصيص على حرمة نكاح الامة عند وجود طول الحرة.
وعندنا النص لا يوجب ذلك ولكن الحكم بعد هذا النص عند وجود طول الحرة على ما كان عليه أن لو لم يرد هذا النص، وقال تعالى: (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله) قال الشافعي لما تعلق بالنص درء العذاب عنها بشرط أن تأتي بكلمات اللعان كان ذلك تنصيصا على إقامة الحد عليها إذا لم تأت بكلمات اللعان.
وعندنا لا يوجب ذلك حتى لا يقام عليها الحد وإن امتنعت من كلمات اللعان.
وجه قول الشافعي أن التعليق بالشرط يؤثر في الحكم دون السبب على اعتبار أنه لولا التعليق لكان الحكم ثابتا فإن قوله لعبده أنت حر موجب عتقه في الحال لولا قوله إن دخلت الدار فبالتعليق
يتأخر نزول العتق ولا ينعدم أصل السبب.
وبهذا تبين أن التعليق كما يوجب الحكم عند وجود الشرط يوجب نفي الحكم قبل وجود الشرط، بمنزلة التأجيل وبمنزلة خيار الشرط في البيع فإنه يدخل على الحكم دون السبب حتى يتأخر الحكم إلى سقوط الخيار مع قيام السبب، وهو نظير التعليق الحسي، فإن تعليق القنديل بحبل من
سماء البيت يمنع وصوله إلى موضع من الارض لولا التعليق ولا يعدم أصله، وبهذا فارق الشرط العلة فإن الحكم يثبت ابتداء بوجود العلة فلا يكون انعدام الحكم قبل وجود العلة مضافا إلى العلة باعتبار أنها نفت الحكم قبل وجودها بل انعدم لانعدام سببه، فأما الشرط فمغير للحكم بعد وجود سببه فكان مانعا من ثبوت الحكم قبل وجوده كما كان مثبتا وجود الحكم عند وجوده، وعلى هذا الاصل لم يجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك، لان تأثير الشروط في منع حكم لولاه كان موجودا بسببه، ولولا التعليق هنا كان لغوا، وشرط قيام الملك في المحل عند التعليق لان السبب لا يتحقق بدون الملك، وتأثير الشرط في تأخير الحكم إلى وجوده بعد تقرر السبب بمنزلة الاجل، فيشترط قيام الملك في المحل عند التعليق ليتقرر السبب ثم يتأخر الحكم إلى وجود الشرط بالتعليق، ولهذا لم يجوز نكاح الامة لمن قدر على نكاح الحرة، لان الحل معلق بشرط عدم طول الحرة بالنص وذلك يوجب نفي الحكم عند وجود طول الحرة كما يوجب إثباته عند عدم طول الحرة.
هذا هو المفهوم من الكلام فإن من يقول لغيره إن دخل عبدي الدار فأعتقه يفهم منه ولا تعتقه إن لم يدخل الدار، والعمل بالنصوص واجب بمنظومها ومفهومها، ولهذا جوز تعجيل الكفارة بعد اليمين قبل الحنث، لان السبب هو اليمين ولهذا تضاف الكفارة إليها، والاصل أن الواجبات تضاف إلى أسبابها، فأما الحنث شرط يتعلق وجوب الاداء به، ويتضح هذا فيما إذا قال إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين، والتعليق بالشرط بمنزلة التأجيل
عنده فلا يمنع جواز التعجيل قبله بمنزلة الدين المؤجل إلا أن هذا في المالي دون البدني، لان تأثير التعليق بالشرط في تأخير وجوب الاداء في الحقوق المالية الوجوب ينفصل عن الاداء من حيث إن الواجب قبل الاداء مال معلوم كما في حقوق العباد، فأما في البدني الواجب فعل يتأدى به فلا يتحقق انفصاله عن الاداء، وبالتعليق بالشرط يتأخر وجوب الاداء فيتأخر تقرر السبب أيضا ضرورة، لان أحدهما لا ينفصل عن الآخر.
ونظيره من حقوق العباد الشراء مع الاستئجار، فإن بشراء العين يثبت الملك ويتم السبب قبل فعل التسليم، وبالاستئجار لا يثبت الملك في المنفعة قبل الاستيفاء لانها لا تبقى وقتين، ولا يتصور تسليمها بعد وجودها بل يقترن التسليم بالوجود، فإنما تصير معقودا عليها مملوكا بالعقد عند الاستيفاء
فكذلك في حقوق الله تعالى يفصل بين المالي والبدني من هذا الوجه، ألا ترى أن من قال لله علي أن أتصدق بدرهم رأس الشهر فتصدق به في الحال جاز لهذا المعنى.
ودليلنا على أن التعليق بالشرط لا يوجب نفي الحكم قبله من الكتاب قوله تعالى: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة) الآية، ولا خلاف أنه يلزمها الحد المذكور جزاء على الفاحشة وإن لم تحصن، وقال تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) وحكم الكتابة لا ينتفي قبل هذا الشرط.
ثم حقيقة الكلام تبتنى على معرفة عمل الشرط فنقول: التعليق بالشرط تصرف في أصل العلة لا في حكمها من حيث إنه يتبين بالتعليق أن المذكور ليس بسبب قبل وجود الشرط ولكن بعرض أن يصير سببا عند وجوده، فأوان وجود الحكم ابتداء حال وجود الشرط بمنزلة ما ذكره الخصم في العلة إلا أن فرق ما بينهما أن الحكم يوجد عند وجود الشرط ابتداء ولكنه يضاف إلى العلة ثبوتا به وإلى الشرط وجودا عنده، فكما أن قبل وجود العلة انعدام الحكم أصل غير مضاف إلى العلة فكذلك قبل وجود الشرط.
وبيان هذا الكلام
من وجهين: أحدهما أن السبب هو الايقاع والمعلق بالشرط يمين وهي غير الايقاع وينتقض اليمين إذا صار إيقاعا بوجود الشرط، والثاني أن صحة الايجاب باعتبار ركنه ومحله، ألا ترى أن شطر البيع كما لا يكون سببا لانعدام تمام الركن فكذلك بيع الحر لا يكون سببا لانه غير مضاف إلى محله، فكذلك في الطلاق والعتاق شطر الكلام الذي هو إيجاب (كما لا يكون سببا فالكلام الذي هو إيجاب) ما لم يتصل بالمحل لا يكون سببا، والتعليق بالشرط يمنع وصوله إلى المحل بالاتفاق ولكنه بعرض أن يتصل بالمحل إذا وجد الشرط كما أن شرط البيع بعرض أن يصير سببا إذا وجد الشطر الثاني.
وكذلك شطر النصاب ليس بسبب للزكاة بمنزلة النصاب الكامل في ملك من ليس بأهل لوجوب الزكاة عليه وهو الكافر ولكن بعرض أن يصير سببا.
ونظيره من الحسيات الرمي فإن نفسه ليس بقتل ولكنه بعرض أن يصير قتلا إذا اتصل بالمحل، وإذا كان هناك مجن منع وصوله إلى المحل فأحد لا يقول بأن المجن مانع لما هو قتل ولكن لما كان يصير قتلا لو اتصل بالمحل عند
عدم المجن فكذلك التعليق بالشرط في الحكميات.
وبهذا تبين أنه وهم حيث جعل التعليق كالتأجيل فإن التأجيل لا يمنع وصول السبب بالمحل لان سبب وجوب التسليم في الدين والعين جميعا العقد، ومحل الدين الذمة، والتأجيل لا يمنع ثبوت الدين في الذمة ولا ثبوت الملك في المبيع وإنما يؤخر المطالبة وهو محتمل السقوط فيسقط الاجل بالتعجيل ويتحقق أداء الواجب، وهنا التعليق يمنع الوصول إلى المحل وقبل الوصول (إلى المحل) لا يتم السبب ولا يتصور أداء الواجب قبل تمام السبب، ولهذا لم نجوز التكفير قبل الحنث لان أدنى درجات السبب أن يكون طريقا إلى الحكم واليمين مانع من الحنث الذي تعلق به وجوب الكفارة على ما قرره، فإنها موجبة للبر والبر يفوت بالحنث وفي الحنث نقض اليمين، كما قال تعالى: (ولا تنقضوا
الايمان بعد توكيدها) ويستحيل أن يقال في شئ إنه سبب لحكم لا يثبت ذلك الحكم إلا بعد انتقاضه، فعرفنا أنه بعرض أن يصير سببا عند وجود الشرط، فلهذا كان مضافا إليه وقبل أن يصير سببا لا يتحقق الاداء، وفرقه بين المالي والبدني باطل، فإن بعد تمام السبب الاداء جائز في البدني والمالي جميعا وإن تأخر وجوب الاداء كالمسافر إذا صام في شهر رمضان، وهذا لان الواجب لله على العبد فعل هو عبادة، فأما المال ومنافع البدن فإنه يتأدى الواجب بهما فكما أن في البدن مع تملق وجوب الاداء بالشرط لا يكون السبب تاما فكذلك في المالي، بخلاف حقوق العباد فإن الواجب للعباد مال لا فعل لان المقصود ما ينتفع منه العبد أو يندفع عنه الخسران به وذلك بالمال دون الفعل، ولهذا إذا ظفر بجنس حقه فاستوفى تم الاستيفاء وإن لم يوجد فعل هو أداء ممن عليه.
فأما حقوق الله تعالى واجبة بطريق العبادة ونفس المال ليس بعبادة إنما العبادة اسم لعمل يباشره العبد بخلاف هوى النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى وفي هذا المالي والبدني سواء، وهذا التعليق لا يشبه بتعليق القنديل بالحبل لان القنديل كان موجودا بذاته قبل التعليق، فعرفنا أن عمل التعليق في تفريغ المكان الذي كان مشغولا به من الارض قبل التعليق، وهنا قبل التعليق ما كان الحكم موجودا فكان تأثير التعليق في تأخير السببية للحكم إلى وجود
الشرط، ولهذا جوزنا تعليق الطلاق والاعتاق بالملك لان المتعلق قبل وجود الشرط يمين ومحل الالتزام باليمين الذمة فأما الملك في المحل إنما يشترط لايجاب الطلاق والاعتاق، وهذا الكلام للحال ليس بإيجاب ولكنه بعرض أن يصير إيجابا، فإن تيقنا بوجود الملك في المحل حين يصير إيجابا بوصوله إلى المحل صححنا التعليق باعتباره، وإن لم نتيقن بذلك بأن كان الشرط مما لا أثر له في إثبات الملك في المحل شرطنا الملك في الحال ليصير كلامه إيجابا عند وجود الشرط باعتبار الظاهر وهو أن
ما علم ثبوته فالاصل بقاؤه ولكن بهذا الظاهر دون الملك الذي يتيقن به عند وجود الشرط فصحة التعليق باعتبار ذلك النوع دليل على صحة التعليق باعتبار هذا الملك بطريق أولى، وليس التعليق كاشتراط الخيار في البيع فإن ذلك لا يدخل على أصل السبب لان البيع لا يحتمل الحظر، وفي جعله متعلقا بشرط لا ندري أن يكون أو لا يكون حظر تام، ولهذا كان القياس أن لا يجوز البيع مع خيار الشرط ولكن السنة جوزت ذلك لحاجة الناس باعتبار أن الخيار دخل على الحكم دون السبب فإن الحكم يحتمل التأخير عن السبب فجعل الحكم متعلقا بشرط إسقاط الخيار مع ثبوت السبب لان السبب محتمل للفسخ فيما هو المقصود وهو دفع الضرر يحصل بهذا الطريق وهو أقل غررا، فأما الطلاق والعتاق فأصل السبب فيهما يحتمل التعليق بالشرط فإذا وجد التعليق نصا يثبت الحظر الكامل فيهما بأن تعلق صيرورتهما سببا بوجود الشرط.
والدليل على الفرق من جهة الحكم أنه لو حلف أن لا يبيع فباع بشرط الخيار حنث في يمينه.
ولو حلف أن لا يطلق امرأته فعلق طلاقها بالشرط لم يحنث ما لم يوجد الشرط، وعلى هذا جوزنا نكاح الامة لمن له طول الحرة لان التعليق بالشرط لا يوجب نفي الحكم قبله فيجعل الحل ثابتا قبل وجود هذا الشرط بالآيات الموجبة لحل الاناث للذكور.
وهكذا نقول في قوله إن دخل عبدي الدار
فأعتقه فإن ذلك لا يوجب نفي الحكم قبله حتى إنه لو كان قال أولا أعتق عبدي ثم قال أعتقه إن دخل الدار جاز له أن يعتقه قبل الدخول بالامر الاول ولا يجعل هذا الثاني نهيا عن الاول.
(فإن قيل: لا خلاف أن الحكم المتعلق بالشرط يثبت عند وجود الشرط، وإذا كان الحكم ثابتا هنا قبل وجود الشرط فكيف يتصور ثبوته عند وجود الشرط إذ لا يجوز أن يكون الحكم الواحد ثابتا في الحال ومتعلقا بشرط منتظر ؟
قلنا: حل الوطئ ليس بثابت قبل النكاح ولكنه متعلق بشرط النكاح في الآيات التي ليس فيها هذا الشرط الزائد ومتعلق بها وبهذا الشرط في هذه الآية، وإنما يتحقق ما ادعى من التضاد فيما هو موجود فأما فيما هو متعلق فلا، لانه يجوز أن يكون الحكم متعلقا بشرط وذلك الحكم بعينه متعلقا بشرط آخر قبله أو بعده، ألا ترى أن من قال لعبده إذا جاء يوم الخميس فأنت حر ثم قال إذا جاء يوم الجمعة فأنت حر كان الثاني صحيحا وإن كان مجئ يوم الجمعة لا يكون إلا بعد مجئ يوم الخميس حتى لو أخرجه من ملكه فجاء يوم الخميس ثم أعاده إلى ملكه فجاء يوم الجمعة يعتق باعتبار التعليق الثاني).
فإن قيل: مع هذا لا يجوز أن يكون الشئ الواحد كمال الشرط لاثبات حكم وهو بعض الشرط لاثبات ذلك الحكم أيضا، وما قلتم يؤدي إلى هذا فإن عقد النكاح كمال الشرط في سائر الآيات سوى قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا) وهو بعض الشرط في هذه الآية إذا قلتم بأن الحكم يثبت ابتداء عند وجود هذا الشرط.
قلنا: إنما لا يجوز هذا بنص واحد فأما بنصين فهو جائز، ألا ترى أنه لو قال لعبده أنت حر إن أكلت ثم قال أنت حر إن أكلت وشربت صح كل واحد منهما ويكون الاكل كمال الشرط بالتعليق الاول وبعض الشرط في التعليق الثاني حتى لو باعه فأكل في غير ملكه ثم اشتراه فشرب فإنه يعتق لتمام الشرط في التعليق الثاني وهو في ملكه.
وعلى هذا الاصل قال زفر رحمه الله: إن التعليق لا يبطل بفوات المحل، حتى لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها ثلاثا لم يبطل التعليق،
ولو قال لامته إن دخلت الدار فأنت حرة ثم أعتقها لم يبطل التعليق حتى إذا ارتدت ولحقت بدار الحرب فسبيت وملكها ثم دخلت الدار عتقت، قال: لان التعليق بالشرط يمنع الوصول إلى المحل والمتعلق بالشرط لا يكون طلاقا ولا سببا
للطلاق قبل وجود الشرط، واشتراط المحلية لتمام السبب وثبوت الحكم عند الوصول إليه بمنزلة اشتراط الملك فكما لا يبطل التعليق بعد صحته بانعدام الملك في المحل بأن باع العبد أو أبان المرأة وانقضت عدتها فكذلك لا يبطل بانعدام المحلية، وهذا لان توهم المحلية عند وجود الشرط قائم كتوهم الملك، وإذا كان يصح ابتداء التعليق باعتبار توهم الملك عند وجود الشرط في هذه اليمين لان الملك الموجود عند التعليق متوهم البقاء عند وجود الشرط لا متيقن البقاء فلان يبقى التعليق صحيحا باعتبار هذا التوهم كان أولى، ألا ترى أن التعليق بالملك يبقى باعتبار هذا المعنى حتى إذا قال لاجنبية كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها وطلقت ثلاثا ثم تزوجها ثانيا بعد زوج تطلق أيضا.
ولكنا نقول بانعدام المحل يبطل التعليق، لان صحة التعليق باعتبار المحلوف به وهو ما يصير طلاقا عند وجود الشرط ولا تصور لذلك بدون المحل وبالتطليقات الثلاث تحقق فوات المحل، لان الحكم الاصلي للطلاق زوال صفة الحل عن المحل ولا تصور لذلك بعد حرمة المحل بالتطليقات الثلاث، فلانعدام المحلوف به من هذا الوجه يبطل التعليق لا لان المتعلق بالشرط تطليقات ذلك الملك.
وتحقيق هذا أنه لا بد لصحة التعليق من المحل (أيضا) حتى لا يصح التعليق بالعتق مضافا إلى البهيمة، إلا أن قيام الملك في المحل لا يشترط لان التعليق بالشرط ليس هو الطلاق المملوك، وإذا كانت صحة التعليق تستدعي المحل لم يبق صحيحا بعد فوات المحل لان فيما يرجع إلى المحل البقاء بمنزلة الابتداء وتوهم المحلية على الوجه الذي قال لا يعتبر لصحة التعليق في الابتداء فإنه لو قال لاجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق أو قال ذلك للمطلقة ثلاثا لم يصح التعليق وإن كان يتوهم الملك والمحلية عند وجود الشرط فإذا لم يعتبر ذلك لصحة التعليق في الابتداء، لا يعتبر لبقائه صحيحا، بخلاف ما إذا صرح بالاضافة إلى الملك، فإن اعتبار ذلك التعليق بالتيقن بالملك والمحلية عند
وجود الشرط.
يوضحه أن المتعلق وإن لم تكن التطليقات المملوكة له ولكن في التعليق
شبهة ذلك على معنى أنه ما صح إلا باعتباره، بمنزلة الغصب فإن موجبه رد العين ولكن فيه شبهة وجوب ضمان القيمة به، وقد اعتبرنا الشبهة حتى أثبتنا الملك عند تقرر الضمان من وقت الغصب، فهنا أيضا لا بد من اعتبار هذه الشبهة، وبعدما أوقع الثلاث قد ذهبت التطليقات المملوكة كلها فلهذا لا يبقى التعليق.
ومن هذه الجملة ما قال الشافعي رحمه الله: إن المطلق محمول على المقيد سواء كان في حادثة واحدة أو في حادثتين، لان الشئ الواحد لا يجوز أن يكون مطلقا ومقيدا، والمطلق ساكت والمقيد ناطق فكان هو أولى بأن يجعل أصلا ويبني المطلق عليه فيثبت الحكم مقيدا بهما كما في نصوص الزكاة، فإن المطلق عن صفة السوم محمول على المقيد بصفة السوم في حكم الزكاة بالاتفاق.
وكذلك نصوص الشهادة، فإن المطلق عن صفة العدالة محمول على المقيد بها في اشتراط العدالة في الشهادات كلها، وكذلك نصوص الهدايا فإن المطلق عن التبليغ وهو هدي المتعة والقران محمول على المقيد بالتبليغ وهو جزاء الصيد، يعني قوله: (هديا بالغ الكعبة) حتى يجب التبليغ في الهدايا كلها.
وكذلك إذا كان في حادثتين لان التقييد بالوصف بمنزلة التعليق بالشرط على ما قررنا، وكما أوجب نفي الحكم فيه قبل وجود الشرط أوجب في نظيره استدلالا به، ولهذا شرط الايمان في الرقبة في كفارة اليمين والظهار استدلالا بكفارة القتل، لان الكل كفارة بالتحرير فيكون بعضها نظير بعض، بمنزلة الطهارة فإن تقييد الايدي بالمرافق في الوضوء جعل تقييدا في نظيره وهو التيمم لان كل واحد منهما طهارة، وهذا بخلاف مقادير الكفارات والعبادات من الصلوات وغيرها لان ثبوتها بالنصوص باسم العلم لا بالصفة التي تجري مجرى الشرط، وقد بينا أن اسم العلم لا يوجب نفي الحكم قبل وجوده في المسمى به فكيف يوجب ذلك في غيره ؟ ولا يلزمني على هذا التتابع في صوم كفارة اليمين فإني لا أوجبه استدلالا بالمقيد بالتتابع في صوم الظهار والقتل لان هذا المطلق يعارض فيه نظائره من النصوص، فمنها مقيد بصفة التتابع
ومنها مقيد بصفة التفرق يعني صوم المتعة، قال تعالى: (وسبعة إذا رجعتم) حتى لو لم يفرق الصوم فيها لم يجز فلا يكون حملها على أحدهما بأولى من الآخر ولاجل هذا التعارض أثبتنا فيها حكم الاطلاق.
ثم هذا يلزمكم فإنكم أثبتم صفة التتابع
في صوم كفارة اليمين اعتبارا بالصوم المقيد بالتتابع في باب الكفارات فذلك يلزمكم اشتراط صفة الايمان في الرقبة في كفارة اليمين اعتبارا بنظيرها في كفارة القتل.
وعندنا هذا أبعد من الاول لان العلة واحدة هناك والحكم مختلف، وهنا الحكم والعلة جميعا مختلف فكيف يمكن تعرف حكم من حكم آخر أو تعرف علة من علة أخرى ؟ ثم الدليل لنا من الكتاب قوله تعالى: (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) وفي الرجوع إلى المقيد ليعرف منه حكم المطلق إقدام على هذا المنهي عنه لما فيه من ترك الابهام فيما أبهم الله تعالى، وإليه أشار ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبهموا ما أبهم الله واتبعوا ما بين.
وقال عمر رضي الله عنه: أم المرأة مبهمة فأبهموها.
وإنما أراد قوله: (وأمهات نسائكم) فإن حرمتها مطلقة وحرمة الربيبة مقيدة بقوله تعالى: (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) وهذا غير مذكور على وجه الشرط بل على وجه الزيادة في تعريف النساء فإن النساء المذكورة في قوله: (وأمهات نسائكم) معرف بالاضافة إلينا، وفي قوله تعالى: (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) زيادة تعريف أيضا، بمنزلة قول الرجل عبد امرأتي وعبد امرأتي البيضاء فلا يكون ذلك في معنى الشرط حتى يكون دليلا على نفي الحكم قبل وجوده كما توهمه الخصم.
وكذلك في كفارة القتل ذكر صفة الايمان في الرقبة لتعريف الرقبة المشروعة كفارة لا على وجه الشرط.
وإنما لا يجزئ الكافر لانها غير مشروعة لا لانعدام شرط الجواز فيما هو مشروع كما لا تجزئ إراقة الدم وتحرير نصف الرقبة، لان الكفارة ما عرفت إلا شرعا، فما ليس بمشروع لا يحصل به التكفير، وفي الموضع الذي هو مشروع
يحصل به التكفير، ولا شك أن انعدام كونه مشروعا في موضع لا يوجب نفي كونه مشروعا في موضع آخر، ولو كان موجبا لذلك لم يجز العمل به مع النص المطلق الذي هو دليل كونه مشروعا.
وبهذا تبين أن فيما ذهب إليه قولا بتناقض الادلة الشرعية أو ترك العمل ببعضها.
ثم للمطلق حكم وهو الاطلاق، فإن للاطلاق معنى معلوما وله حكم معلوم وللمقيد كذلك، فكما لا يجوز حمل المقيد على المطلق لاثبات حكم الاطلاق فيه لا يجوز حمل المطلق على المقيد لاثبات حكم التقييد فيه، ولئن سلمنا
أن القيد المذكور بمنزلة الشرط وأنه يوجب نفي الحكم قبله فيه فلا يوجب ذلك في غيره ما لم تثبت المماثلة (بينهما ولا مماثلة) في المعنى بين أم المرأة وابنتها، لان أم المرأة تبرز إلى زوج ابنتها قبل الزفاف عادة، والربيبة تمنع من ذلك بعد الزفاف فضلا عما قبله.
وكذلك لا مماثلة بين سبب كفارة القتل وبين سائر أسباب الكفارة فإن القتل بغير حق لا يكون في معنى الجناية كالظهار أو اليمين، ولا مماثلة في الحكم أيضا، فالرقبة عين في كفارة القتل ولا مدخل للاطعام فيها، والصوم مقدر بشهرين متتابعين، وفي الظهار للاطعام مدخل عند العجز عن الصوم، وفي اليمين يتخير بين ثلاثة أشياء ويكفي إطعام عشرة مساكين، وعند العجز يتأدى بصوم ثلاثة أيام، فمع انعدام المماثلة في السبب والحكم كيف يجعل ما يدل على نفي الحكم في كفارة القتل دليلا على النفي في كفارة اليمين والظهار، وإذا كان هو لا يعتبر الصوم في كفارة اليمين بالصوم في سائر الكفارات في صفة التتابع لانعدام المماثلة فكيف يستقيم منه اعتبار الرقبة في كفارة اليمين بالرقبة في كفارة القتل ؟ وما ذكره من العذر باطل، فالمطلق في كفارة إنما يحمل على المقيد في الكفارة أيضا وليس في صوم الكفارة مقيد بالتفرق، فإن صوم المتعة ليس بكفارة بل هو نسك بمنزلة إراقة الدم الذي كان الصوم خلفا عنه، ثم هو غير مقيد بالتفرق فإنه وإن فرقه
قبل الرجوع لا يجوز ولكنه مضاف إلى وقت بحرف إذا، كما قال تعالى: (وسبعة إذا رجعتم) والمضاف إلى وقت لا يجوز قبل ذلك الوقت كصوم رمضان قبل شهود الشهر وصلاة الظهر قبل زوال الشمس.
وعندنا شرط التتابع فيه ليس بحمل المطلق على المقيد بل بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وقراءته لا تكون دون خبر يرويه، وقد كان مشهور إلى عهد أبي حنيفة رحمه الله، وبالخبر المشهور تثبت الزيادة على النص على ما نبينه.
فإن قيل: لماذا لم تجعلوا قراءته كنص آخر ثم عملتم بهما جميعا كما فعلتم في صدقة الفطر حيث أوجبتم الصدقة عن العبد الكافر بالنص المطلق، وعن العبد المسلم بالنص المقيد ؟ قلنا: لان الحكم هنا واحد وهو تأدي الكفارة بالصوم فبعدما صار مقيدا
بنص لا يبقى ذلك الحكم بعينه مطلقا.
فأما في صدقة الفطر النصان في بيان السبب دون الحكم وأحد السببين لا ينفي السبب الآخر، فيجوز أن يكون ملك العبد المطلق سببا لوجوب صدقة الفطر بأحد النصين، وملك العبد المسلم سببا بالنص الآخر.
وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الارض باعتبار النص المطلق وهو قوله عليه السلام: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وبالتراب باعتبار النص المقيد وهو قوله عليه السلام: التراب طهور المسلم لان المحل مختلف وإن كان الحكم واحدا فيستقيم إثبات المحلية باعتبار كل نص في شئ آخر، فأما التيمم إلى المرافق فلم نشترطه بحمل المطلق على المقيد، إذ لو جاز ذلك لكان الاولى إثبات التيمم في الرأس والرجل اعتبارا بالوضوء، وإنما عرفنا ذلك بنص فيه وهو حديث الاسلع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين وهو مشهور يثبت بمثله التقييد، فإذا صار مقيدا لا يبقى ذلك الحكم بعينه مطلقا.
فأما صفة السائمة في الزكاة فهو ثابت بالنص المقيد
وإنما لا نوجب الزكاة في غير السائمة لنص موجب للنفي وهو قوله عليه السلام لا زكاة في العوامل لا باعتبار حمل المطلق على المقيد.
واشتراط العدالة في الشهادات باعتبار وجوب التوقف (وهو قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) أي توقفوا) في خبر الفاسق بالنص، وباعتبار قوله تعالى: (ممن ترضون من الشهداء) والفاسق لا يكون مرضيا، لا بحمل المطلق على المقيد.
واشتراط التبليغ في الهدايا باعتبار النص الوارد فيه وهو أن الله تعالى بعد ذكر الهدايا قال: (ثم محلها إلى البيت العتيق) أو بمقتضى اسم الهدي فإنه اسم لما يهدي إلى موضع.
وبمجرد اسم الكفارة لا تثبت المماثلة بين واجبات متفاوتة في أنفسها ليتعرف حكم بعضها من بعض، كما لا تثبت المماثلة بين الصلوات في مقدار الركعات والشرائط نحو الخطبة والجماعة في صلاة الجمعة حتى يعتبر بعضها ببعض وإن جمعها اسم الصلاة.
وصار حاصل الكلام أن النفي ضد الاثبات، فالنص الموجب لاثبات حكم لا يوجب ضد ذلك الحكم بعبارته
ولا بإشارته ولا بدلالته ولا بمقتضاه، لانه ليس من جملة ما لا يستغنى عنه حتى يكون مقتضيا إياه، فإثبات النفي به بعد هذا لا يكون إلا إثبات الحكم بلا دليل والاحتجاج بلا حجة وذلك باطل على ما نثبته في بابه إن شاء الله تعالى.
ونحن إذا قلنا يثبت بالمطلق حكم الاطلاق وبالمقيد حكم التقييد فقد عملنا بكل دليل بحسب الامكان، والتفاوت بين العمل بالدليل وبين العمل بلا دليل لا يخفى على كل متأمل.
ومن هذا الجنس ما قاله الشافعي رحمه الله: إن الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، والنهي عن الشئ يكون أمرا بضده، وقد بينا فساد هذا الكلام فيما سبق.
ومن هذه الجملة قول بعض العلماء: إن العام يختص بسببه، وعندنا هذا على أربعة أوجه: أحدها: أن يكون السبب منقولا مع الحكم نحو ما روي أن النبي
صلى الله عليه وسلم سها فسجد، وأن ماعزا زنى فرجم، ونحو قوله تعالى: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) وهذا يوجب تخصيص الحكم بالسبب المنقول لانه لما نقل معه فذلك تنصيص على أنه بمنزلة العلة للحكم المنصوص، وكما لا يثبت الحكم بدون علية لا يبقى بدون العلة مضافا إليها بل البقاء بدونها يكون مضافا إلى علة أخرى.
والثاني: أن لا يكون السبب منقولا ولكن المذكور مما لا يستقل بنفسه ولا يكون مفهوما بدون السبب المعلوم به، فهذا يتقيد به أيضا نحو قول الرجل أليس لي عندك كذا فيقول بلى، أو يقول أكان من الامر كذا فيقول نعم أو أجل.
فهذه الالفاظ لا تستقل بنفسها مفهومة المعنى فتتقيد بالسؤال المذكور الذي كان سببا لهذا الجواب حتى جعل إقرارا بذلك، وباعتبار أصل اللغة بلى موضوع للجواب عن صيغة نفي فيه معنى الاستفهام، كما قال تعالى: (ألست بربكم قالوابلى) ونعم جواب لما هو محض الاستفهام، قال تعالى: (فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم) وأجل تصلح لهما.
وقد تستعمل بلى ونعم في جواب ما ليس باستفهام على أن يقدر فيه معنى الاستفهام، أو يكون مستعارا عنه.
هذا مذهب أهل اللغة.
فأما محمد رحمه الله فقد ذكر في كتاب الاقرار مسائل بناها على هذه الكلمات من غير استفهام في السؤال أو احتمال استفهام وجعلها إقرارا صحيحا بطريق الجواب، وكأنه ترك اعتبار حقيقة اللغة فيها لعرف الاستعمال.
والثالث: أن يكون مستقلا بنفسه مفهوم المعنى ولكنه خرج جوابا للسؤال وهو غير زائد على مقدار الجواب، فبهذا يتقيد بما سبق ويصير ما ذكر في السؤال كالمعاد في الجواب لانه بناء عليه.
وبيان هذا فيما إذا قال لغيره تعال تغد معي فقال إن تغديت فعبدي حر، فهذا يختص بذلك الغداء، ولو قالت له امرأته إنك تغتسل في هذه الدار الليلة من جنابة فقال إن اغتسلت فعبدي حر فإنه يختص بذلك
الاغتسال المذكور في السؤال.
والرابع: أن يكون مستقلا بنفسه زائدا على ما يتم به الجواب بأن يقول: إن تغديت اليوم أو إن اغتسلت الليلة، فموضع الخلاف هذا الفصل.
فعندنا لا يختص مثل هذا العام بسببه، لان في تخصيصه به إلغاء الزيادة وفي جعله نصا مبتدأ اعتبار الزيادة التي تكلم بها، وإلغاء الحال والعمل بالكلام لا بالحال، فإعمال كلامه مع إلغاء الحال أولى من إلغاء بعض كلامه، وفيما لا يستقل بنفسه قيدناه بالسبب باعتبار أن الكل صار بمنزلة المذكور وبمنزلة كلام واحد فلا يجوز إعمال بعضه دون البعض، ففي هذا الموضع لان لا يجوز إعمال بعض كلامه وإلغاء البعض كان أولى، إلا أن يقول نويت الجواب فحينئذ يدين فيما بينه وبين الله تعالى وتجعل تلك الزيادة للتوكيد.
وعلى قول بعض العلماء هذا يحمل على الجواب أيضا باعتبار الحال فيكون ذلك عملا بالمسكوت وتركا للعمل بالدليل، لان الحال مسكوت عنه والاستدلال بالمسكوت يكون استدلالا بلا دليل، فكيف يجوز باعتباره ترك العمل بالدليل وهو المنصوص ؟ والدليل على صحة ما قلنا إن بين أهل التفسير اتفاقا أن نزول آية الظهار كان بسبب خولة ثم لم يختص الحكم بها، ونزول آية القذف كان بسبب قصة عائشة رضي الله عنها ثم لم يختص بها، ونزول آية اللعان كان بسبب ما قال سعد بن عبادة ثم لم يختص به، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة
فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فقد كان سبب هذا النص إسلامهم إلى أجل مجهول ثم لم يختص هذا النص بذلك السبب.
وأمثلة هذا كثير، فعرفنا أن العام لا يختص بسببه.
ومن هذه الجملة تخصيص العام بغرض المتكلم، فإن من الناس من يقول يختص الكلام بما يعلم من غرض المتكلم لانه يظهر بكلامه غرضه، فيجب بناء كلامه في العموم
والخصوص والحقيقة والمجاز على ما يعلم من غرضه، ويجعل ذلك الغرض كالمذكور.
وعلى هذا قالوا: الكلام المذكور للمدح والذم والثناء والاستثناء لا يكون له عموم، لانا نعلم أنه لم يكن غرض المتكلم به العموم.
وعندنا هذا فاسد لانه ترك موجب الصيغة بمجرد التشهي وعمل بالمسكوت، فإن الغرض مسكوت عنه، فكيف يجوز العمل بالمسكوت وترك العمل بالمنصوص باعتباره ؟ ولكن العام يعرف بصيغته فإذا وجدت تلك الصيغة وأمكن العمل بحقيقتها يجب العمل، والامكان قائم مع استعمال الصيغة للمدح والذم (فإن المدح العام والثناء العام من عادة أهل اللسان، وكذلك الاستثناء والذم) واعتبار الغرض اعتبار نوع احتمال ولاجله لا يجوز ترك العمل بحقيقة الكلام.
ومن ذلك ما قاله بعض الاحداث من الفقهاء: إن القرآن في النظم يوجب المساواة في الحكم، وبيان هذا في قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) فإن هذه جمل قرن بعضها ببعض بحرف النظم وهو الواو وقالوا يستوي حكمها في الحج.
وقال بعض أصحابنا في قوله تعالى: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) إن ذلك يوجب سقوط الزكاة عن الصبي، لان القران في النظم دليل المساواة في الحكم فلا تجب الزكاة على من لا تجب عليه الصلاة.
وعندنا هذا فاسد وهو من جنس العمل بالمسكوت وترك العمل بالدليل لاجله، فإن كلا من الجمل معلوم بنفسه وليس في واو النظم دليل المشاركة بينهما في الحكم إنما ذلك في واو العطف، وفرق ما بينهما أن واو النظم تدخل بين جملتين كل واحدة منهما تامة بنفسها مستغنية عن خبر الآخر كقول الرجل جاءني زيد وتكلم عمرو فذكر الواو بينهما لحسن النظم به
لا للعطف.
وبيان هذا في قوله تعالى: (لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء) وقال تعالى: (فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل) وأما واو العطف فإنه يدخل بين جملتين أحدهما ناقص والآخر تام بأن لا يكون خبر الناقص مذكورا
فلا يكون مفيدا بنفسه، ولا بد من جعل الخبر المذكور للاول خبرا للثانية حتى يصير مفيدا، كقول الرجل جاءني زيد وعمرو، فهذا الواو للعطف، لانه لم يذكر لعمرو خبرا ولا يمكن جعل (هذا) الخبر الاول خبرا له إلا بأن يجعل الواو للعطف حتى يصير ذلك الخبر كالمعاد لان موجب العطف الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر، فمن قال بالقول الاول فقد ذهب إلى التسوية بين واو العطف وواو النظم باعتبار أن الواو في أصل اللغة للعطف، وموجب العطف الاشتراك، ومطلق الاشتراك يقتضي التسوية، فذلك دليل على أن القران في النظم يوجب المساواة في الحكم.
ثم الاصل أنا نفهم من خطاب صاحب الشرع ما يتفاهم من المخاطبات بيننا، ومن يقول امرأته طالق وعبده حر إن دخل الدار فإنه يقصد الاشتراك بين المذكورين في التعليق بالشرط، وذلك يفهم من كلامه حتى يجعل الكل متعلقا بالشرط وإن كان كل واحد من الكلامين تاما لكونه مبتدأ وخبرا مفهوم المعنى بنفسه، فعليه يحمل أيضا مطلق كلام صاحب الشرع.
ولكنا نقول: المشاركة في الخبر عند واو العطف لحاجة الجملة الناقصة إلى الخبر لا لعين الواو، وهذه الحاجة تنعدم في واو النظم، لان كل واحد من الكلامين تام بما ذكر له من الخبر فكان هذا الواو ساكتا عما يوجب المشاركة فإثبات المشاركة به يكون استدلالا بالمسكوت، يوضحه أنه لو كانت المشاركة تثبت باعتبار هذا الواو لثبتت في خبر كل جملة إذ ليس خبر إحدى الجملتين بذلك بأولى من الآخر، وهذا خلاف ما عليه إجماع أهل اللسان، فأما إذا قال امرأته طالق وعبده حر إن دخل الدار فكل واحد منهما تام في نفسه إيقاعا لا تعليقا بالشرط، والتعليق تصرف سوى الايقاع، ففيما يرجع إلى التعليق إحدى الجملتين ناقصة فأثبتنا المشاركة بينهما في حكم التعليق بواو العطف، حتى إذا لم يذكر الشرط وكان كلامه إيقاعا لم تثبت المشاركة بينهما في الخبر وجعل واو النظم
لتحسين الكلام به فإنه مستعمل كما بينا، ولهذا لو قال: لفلان علي مائة دينار ولفلان ألف درهم إلا عشرة يجعل الاستثناء من آخر المالين ذكرا لان بالاستثناء لا يخرج الكلام من أن يكون إقرارا وباعتبار الاقرار كل واحد من الجملتين تامة فيكون الواو للنظم وينصرف الاستثناء إلى ما يليه خاصة.
وعلى هذا قلنا في قوله تعالى: (وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) إن هذا الواو للنظم حتى ينصرف الاستثناء إلى سمة الفسق دون ما تقدمه.
والشافعي يجعل هذا الواو للعطف والواو الذي في قوله: (ولا تقبلوا لهم) للنظم حتى يكون الاستثناء منصرفا إليهما دون الجلد فلا يسقط الجلد بالتوبة.
والصحيح ما قلنا: فإن من حيث الصيغة معنى العطف يتحقق في قوله تعالى: (ولا تقبلوا) ولا يتحقق في قوله تعالى: (وأولئك هم الفاسقون) لان قول القائل اجلس ولا تتكلم يكون عطفا صحيحا فكذلك قوله تعالى: (فاجلدوا) .
(ولا تقبلوا) لان كل واحد منهما خطاب للائمة، فأما قوله تعالى: (وأولئك هم الفاسقون) ليس بخطاب للائمة ولكن إخبار عن وصف القاذفين فلا يصلح معطوفا على ما هو خطاب فجعلناه للنظم، وكذلك من حيث المعنى قوله تعالى: (ولا تقبلوا) صالح لان يكون متمما للحد معطوفا على الجلد، فإن إهدار قوله في الشهادات شرعا مؤلم كالجلد وهذا الالم عند العقلاء يزداد على ألم الجلد فيصلح متمما للحد زاجرا عن سببه ولهذا خوطب به الائمة فإن إقامة الحد إليهم، فأما قوله تعالى: (وأولئك هم الفاسقون) فمعناه العاصون وذلك بيان لجريمة القاذف فلا يصلح جزاء على القذف حتى يكون متمما للحد، بل المقصود به إزالة إشكال كان يقع عسى وهو أن القذف خبر متميل، وربما يكون حسبة إذا كان الرامي صادقا وله أربعة من الشهود والزاني مصر فكان يقع الاشكال أنه لما كان سببا لوجوب عقوبة تندرئ بالشبهات فأزال الله هذا الاشكال بقوله: (وأولئك هم الفاسقون) أي العاصون بهتك ستر العفة من غير فائدة حين عجزوا عن إقامة أربعة من الشهداء، وإليه أشار في قوله
تعالى: (فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) ويتبين بهذا التحقيق أن العمل بالنص كما يوجبه فيما قلنا فإنا جعلنا العجز عن إقامة أربعة من الشهداء