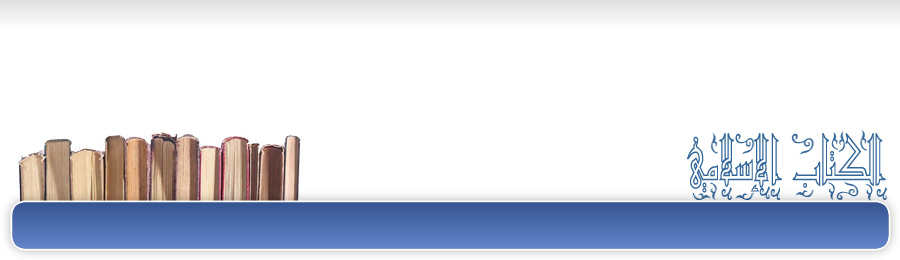الكتاب : أصول السرخسي
المؤلف : ابى بكر محمد بن احمد بن ابى سهل السرخسى
وهذا بخلاف النسخ فإن الواجب اعتقاد الحقية في الحكم النازل، فأما في حياة رسول الله عليه السلام فما كان يجب اعتقاد التأبيد في ذلك الحكم، ولا إطلاق القول بأنه مؤبد، لان الوحي كان ينزل ساعة فساعة ويتبدل الحكم كالصلاة إلى بيت المقدس وتحريم شرب الخمر وما أشبه ذلك، وإنما اعتقاد التأبيد فيه وإطلاق القول به بعد رسول الله لقيام الدليل على أن شريعته لا تنسخ بعده بشريعة أخرى.
فأما قوله تعالى (ثم إن علينا بيانه) فنقول: بالاتفاق ليس المراد جميع ما في القرآن فإن البيان من القرآن أيضا فيؤدي هذا القول بأن لذلك البيان بيانا إلى ما لا يتناهى، وإنما المراد بعض ما في القرآن وهو المجمل الذي يكون بيانه تفسيرا له ونحن نجوز تأخير البيان في مثله، فأما فيما يكون مغيرا أو مبدلا للحكم إذا اتصل به، فإذا تأخر عنه يكون نسخا ولا يكون بيانا محضا، ودليل الخصوص في العام بهذه الصفة.
ونظيره المحكمات التي هن أم الكتاب، فإن فيها ما لا يحتمل النسخ ويحتمل بيان التقرير كصفات الله جل جلاله، فكذلك ما ورد من العام مطلقا قلنا إنه يحتمل البيان الذي هو نسخ، ولكنه لا يحتمل البيان المحض وهو ما يكون تفسيرا له إذا كان منفصلا عنه.
فأما قوله تعالى: (قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك) قلنا البيان هنا موصول فإنه قال: (إلا من سبق عليه القول) والمراد ما سبق من وعد إهلاك الكفار بقوله تعالى: (إنهم مغرقون) .
فإن قيل: ففي ذلك الوعد نهي لنوح عليه الصلاة والسلام عن الكلام فيهم كما قال تعالى: (ولا تخاطبني في الذين ظلموا) فلو كان قوله (إلا من سبق عليه القول) منصرفا إلى ذلك لما استجاز نوح عليه الصلاة والسلام سؤال ابنه بقوله (إن ابني من أهلي) قلنا: إنما سأل لانه كان دعاه إلى الايمان وكان يظن فيه أنه يؤمن حين تنزل الآية الكبرى وامتد رجاؤه لذلك إلى أن آيسه الله تعالى من ذلك بقوله تعالى: (إنه عمل غير صالح) فأعرض عنه عند ذلك وقال: (رب إني أعوذ
بك أن أسألك ما ليس لي به علم) ونظيره استغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لابيه (بناء على رجاء أن يؤمن كما وعد، وإليه أشار في قوله تعالى: (وما كان استغفار إبراهيم
لابيه) إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) ثم قوله تعالى: (وأهلك) ما تناول ابنه الكافر، لان أهل المرسلين من يتابعهم على دينهم، وعلى هذا لفظ الاهل كان مشتركا فيه لاحتمال أن يكون المراد الاهل من حيث النسب واحتمال أن يكون المراد الاهل من حيث المتابعة في الدين، فلهذا سأل الله فبين الله له أن المراد أهله من حيث المتابعة في الدين وأن ابنه الكافر ليس من أهله وتأخير البيان في المشترك صحيح عندنا.
فأما قوله تعالى: (إنا مهلكو أهل هذه القرية) فالبيان هنا موصول في هذه الآية بقوله: (إن أهلها كانوا ظالمين) وفي موضع آخر بقوله: (إلا آل لوط) .
فإن قيل: فما معنى سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرسل بقوله: (إن فيها لوطا) ؟ قلنا: فيه معنيان: أحدهما أن العذاب النازل قد يخص الظالمين كما في قصة أصحاب السبت، وقد يصيب الكل فيكون عذابا في حق الظالمين ابتلاء في حق المطيعين، كما قال تعالى: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فأراد الخليل عليه السلام أن يبين له أن عذاب أهل تلك القرية من أي الطريقين وأن يعلم أن لوطا عليه السلام هل ينجو من ذلك أم يبتلى به ؟ والثاني أنه علم يقينا أن لوطا ليس من المهلكين معهم ولكنه خصه في سؤاله ليزداد طمأنينة وليكون فيه زيادة تخصيص للوط.
وهو نظير قوله تعالى: (رب أرني كيف تحيي الموتى) وقد كان عالما متيقنا بإحياء الموتى ولكن سأله لينضم العيان إلى ما كان له من علم اليقين فيزداد به طمأنينة قلبه.
فأما قوله تعالى: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) فقد قيل إن هذا الخطاب كان لاهل مكة وهم كانوا عبدة الاوثان، وما كان فيهم من يعبد عيسى
عليه الصلاة والسلام والملائكة فلم يكن أصل الكلام متناولا لهم.
والاوجه أن يقول إن في صيغة الكلام ما هو دليل ظاهر على أنه غير متناول لهم، فإن كلمة ما يعبر بها عن ذات ما لا يعقل وإنما يعبر عن ذات من يعقل بكلمة من، إلا أن القوم كانوا متعنتين يجادلون بالباطل بعد ما تبين لهم فحين عارضوا بعيسى والملائكة عليه السلام علم رسول الله عليه السلام تعنتهم في ذلك، وأنهم يعلمون أن الكلام غير
متناول لمن عارضوا به، وقد كانوا أهل اللسان فأعرض عن جوابهم امتثالا بقوله تعالى: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) ثم بين الله تعالى تعنتهم فيما عارضوا به بقوله: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) ومثل هذا الكلام يكون ابتداء كلام هو حسن وإن لم يكن محتاجا إليه في حق من لا يتعنت، وإنما كلامنا فيما يكون محتاجا إليه من البيان ليوقف به على ما هو المراد.
والذي يوضح تعنت القوم أنهم كانوا يسمونه مرة ساحرا ومرة مجنونا وبين الوصفين تناقض بين، فالساحر من يكون حاذقا في عمله حتى يلبس على العقلاء، والمجنون من لا يكون مهتديا إلى الاعمال والاقوال على ما عليه أصل الوضع، ولكنهم لشدة الحسد كانوا يتعنتون وينسبونه إلى ما يدعو إلى تنفير الناس عنه، من غير تأمل في التحرز عن التناقض واللغو.
فأما قصة بقرة بني إسرائيل فنقول: كان ذلك بيانا بالزيادة على النص وهو يعدل النسخ عندنا والنسخ إنما يكون متأخرا عن أصل الخطاب، وإلى هذا أشار ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو أنهم عمدوا إلى أي بقرة كانت فذبحوها لاجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم.
فدل أن الامر الاول قد كان فيه تخفيف وأنه قد انتسخ ذلك بأمر فيه تشديد عليهم.
فأما قوله: (ولذي القربى) فقد قيل إنه مشترك يحتمل أن يكون المراد قربى النصرة، ويحتمل أن يكون المراد قربى القرابة، فلهذا سأل عثمان وجبير بن مطعم
رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد قربى النصرة.
أو نقول: قد علمنا أنه ليس المراد من يناسبه إلى أقصى أب فإن ذلك يوجب دخول جميع بني آدم فيه، ولكن فيه إشكال أن المراد من يناسبه بأبيه خاصة أو بجده أو أعلى من ذلك، فبين رسول الله عليه السلام أن المراد من يناسبه إلى هاشم، ثم ألحق بهم بني المطلب لانضمامهم إلى بني هاشم في القيام بنصرته في الجاهلية والاسلام، فلم يكن هذا البيان من تخصيص العام في شئ، بل هذا بيان المراد في العام الذي يتعذر فيه القول بالعموم، وقد بينا أن مثل هذا العام في حكم العمل به كالمجمل كما في قوله: (وما يستوي الاعمى والبصير) فيكون البيان تفسيرا له فلهذا صح متأخرا.
فأما تقييد حكم الميراث بالموافقة في الدين
فهو زيادة على النص وهو يعدل النسخ عندنا فلا يكون بيانا محضا.
فأما قصر حكم تنفيذ الوصية على الثلث وجوبا قبل الميراث فيحتمل أن السنة المبينة له كانت قبل نزول آية الميراث فيكون ذلك بيانا مقارنا لما نزل في حقنا باعتبار المعنى، فإنه لما سبق علمنا بما نزل كان من ضرورته أن يكون مقارنا له.
فأما البيان المتأخر في الازمان فهو نسخ ونحن لا ندعي إلا هذا، فإنا نقول إنما يكون دليل الخصوص بيانا محضا إذا كان متصلا بالعام، فأما إذا كان متأخرا عنه يكون نسخا.
فتبين أن ما استدل به من الحجة هو لنا عليه.
وسنقرره في باب النسخ إن شاء الله تعالى.
فصل: في بيان التغيير والتبديل أما بيان التغيير: هو الاستثناء، كما قال تعالى: (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) فإن الالف اسم موضوع لعدد معلوم فما يكون دون ذلك العدد يكون غيره لا محالة، فلولا الاستثناء لكان العلم يقع لنا بأنه لبث فيهم ألف سنة، ومع الاستثناء إنما يقع العلم لنا بأنه لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما، فيكون هذا تغييرا لما كان
مقتضى مطلق تسمية الالف.
وبيان التبديل: هو التعليق بالشرط، كما قال الله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) فإنه يتبين به أنه لا يجب إيتاء الاجر بعد العقد إذا لم يوجد الارضاع، وإنما يجب ابتداء عند وجود الارضاع، فيكون تبديلا لحكم وجوب أداء البدل بنفس العقد.
وإنما سمينا كل واحد منهما بهذا الاسم لما ظهر من أثر كل واحد منهما، فإن حد البيان غير حد النسخ، لان البيان إظهار حكم الحادثة عند وجوده ابتداء، والنسخ رفع للحكم بعد الثبوت، وعند وجود الشرط يثبت الحكم ابتداء ولكن بكلام كان سابقا على وجود الشرط تكلما به، إلا أنه لم يكن موجبا حكمه إلا عند وجود الشرط، فكان بيانا من حيث إن الحكم ثبت عند وجوده ابتداء، ولم يكن نسخا صورة من حيث إن النسخ هو رفع الحكم بعد ثبوته في محله، فكان تبديلا من حيث إن مقتضى قوله لعبده أنت حر نزول العتق
في المحل واستقراره فيه، وأن يكون علة للحكم بنفسه، وبذكر الشرط يتبدل ذلك كله، لانه يتبين به أنه ليس بعلة تامة للحكم قبل الشرط، وأنه ليس بإيجاب للعتق بل هو يمين، وأن محله الذمة حتى لا يصل إلى العبد إلا بعد خروجه من أن يكون يمينا بوجود الشرط، فعرفنا أنه تبديل.
وكذلك الاستثناء، فإن قوله لفلان علي ألف درهم مقتضاه وجوب العدد المسمى في ذمته ويتغير ذلك بقوله إلا مائة، لا على طريق أنه يرتفع بعض ما كان واجبا ليكون نسخا، فإن هذا في الاخبار غير محتمل، ولكن على طريق أنه يصير عبارة عما وراء المستثنى فيكون إخبارا عن وجوب تسعمائة فقط، فعرفنا أنه تغيير لمقتضى صيغة الكلام الاول، وليس بتبديل، إنما التبديل أن يخرج كلامه من أن يكون إخبارا بالواجب أصلا، فلهذا سميناه بيان التغيير.
ثم لا خلاف بين العلماء في هذين النوعين من البيان أنه يصح موصولا بالكلام ولا يصح مفصولا ممن لا يملك النسخ، وإنما يختلفون في كيفية إعمال الاستثناء والشرط.
فقال علماؤنا: موجب الاستثناء أن الكلام به يصير عبارة عما وراء المستثنى، وأنه ينعدم ثبوت الحكم في المستثنى لانعدام الدليل الموجب له مع صورة التكلم به، بمنزلة الغاية فيما يقبل التوقيت فإنه ينعدم الحكم فيما وراء الغاية لانعدام الدليل الموجب له، لا لان الغاية توجب نفي الحكم فيما وراءه.
وعلى قول الشافعي الحكم لا يثبت في المستثنى لوجود المعارض كما أن دليل الخصوص يمنع ثبوت حكم العام فيما يتناوله دليل الخصوص لوجود المعارض.
وكذلك الشرط عندنا فإنه يمنع ثبوت الحكم في المحل لانعدام العلة الموجبة له حكما مع صورة التكلم به، لا لان الشرط مانع من وجود العلة، وعلى قوله الشرط مانع للحكم مع وجود علته.
والكلام في فصل الشرط قد تقدم بيانه إنما الكلام هنا في الاستثناء، فإنهم احتجوا باتفاق أهل اللسان أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفي، فهذا تنصيص على أن الاستثناء موجب ما هو ضد موجب أصل الكلام على وجه المعارضة له في المستثنى، وعليه دل قوله تعالى: (قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين
إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته) فالاستثناء الاول كان من المهلكين ثم فهم منه الانجاء، والاستثناء الثاني من المنجين فإنما فهم منه أنهم من المهلكين.
وعلى هذا قالوا: إذا قال لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهمين يلزمه تسعة، لان الاستثناء الاول من الاثبات فكان نفيا، والاستثناء الثاني من النفي فكان إثباتا، والدليل عليه قوله تعالى: (فشربوا منه إلا قليلا منهم) : أي إلا قليلا منهم لم يشربوا، فقد نص على هذا في قوله تعالى: (إلا إبليس لم يكن من الساجدين) وإذا ثبت أن المراد بالكلام هذا كان في موجبه كالمنصوص عليه، والدليل عليه
كلمة الشهادة فإنها كلمة التوحيد لاشتمالها على النفي والاثبات، وإنما يتحقق ذلك إذا جعل كأنه قال إلا الله فإنه هو الاله، والدليل عليه أن صيغة الايجاب إذا صح من المتكلم فهو مفيد حكمه إلا أن يمنع منه مانع وبالاستثناء لا ينتفي التكلم بكلام صحيح في جميع ما تناوله أصل الكلام، ولو لم يكن الاستثناء موجبا هو معارض مانع لما امتنع ثبوت الحكم فيه، لان بالاستثناء لا يخرج من أن يكون متكلما به فيه، لاستحالة أن يكون متكلما به غير متكلم في كلام واحد، ولكن يجوز أن يكون متكلما به ويمتنع ثبوت الحكم فيه لمانع منع منه كما في البيع بشرط الخيار، فعرفنا أن الطريق الصحيح في الاستثناء هذا، وعليه خرج مذهبه فقال في قوله تعالى: (إلا الذين تابوا) في آية القذف: إن المراد إلا الذين تابوا فأولئك هم الصالحون وتقبل شهادتهم، إلا أنه لا يتناول هذا الاستثناء الجلد على وجه المعارضة، لانه استثناء لبعض الاحوال بإيجاب حكم فيه سوى الحكم الاول وهو حال ما بعد التوبة فيختص بما يحتمل التوقيت دون ما لا يحتمل التوقيت، وإقامة الجلد لا يحتمل ذلك، فأما رد الشهادة والتفسيق يحتمل ذلك.
وقال في قوله عليه السلام: لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء إن المراد لكن إن جعلتموه سواء بسواء فبيعوا أحدهما بالآخر حتى أثبت بالحديث حكمين: حكم الحرمة لمطلق الطعام (بالطعام) فأثبته في القليل والكثير، وحكم الحل بوجود المساواة كما هو موجب الاستثناء فيختص بالكثير الذي يقبل المساواة.
وهو نظير قوله تعالى: (فنصف ما فرضتم
إلا أن يعفون) في أن الثابت به حكمان حكم بنصف المفروض بالطلاق فيكون عاما فيمن يصح منه العفو ومن لا يصح العفو منه نحو الصغيرة والمجنونة، وحكم سقوط الكل بالعفو كما هو موجب الاستثناء فيختص بالكبيرة العاقلة التي يصح منها العفو.
وعلى هذا إذا قال: لفلان علي ألف درهم إلا ثوبا فإنه يلزمه
الالف إلا قدر قيمة الثوب، لان موجب الاستثناء نفي الحكم في المستثنى بدليل المعارض والدليل المعارض يجب العمل به بحسب الامكان والامكان هنا أن يجعل موجبه نفي مقدار قيمة ثوب لا نفي عين الثوب، ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف فيما إذا قال له علي ألف درهم إلا كر حنطة: إنه ينقص من الالف قدر قيمة كر حنطة وإن الاستثناء يصحح بحسب الامكان على الوجه الذي قلنا، بخلاف ما يقوله محمد رحمه الله إنه لا يصح الاستثناء.
قال: ولو كان الكلام عبارة عما وراء المستثنى من الوجه الذي قلتم لكان يلزمه الالف هنا كاملا لان مع وجوب الالف عليه نحن نعلم أنه لا كر عليه فكيف يجعل هذا عبارة عما وراء المستثنى، والكلام لم يتناول المستثنى أصلا، فظهر أن الطريق فيه ما قلنا.
وحجتنا في إبطال طريقة الخصم الاستثناء المذكور في القرآن فيما هو خبر نحو قوله تعالى: (فشربوا منه إلا قليلا منهم) .
(فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) فإن دليل المعارضة في الحكم إنما يتحقق في الايجاب دون الخبر لان ذلك يوهم الكذب باعتبار صدر الكلام ومع بقاء أصل الكلام للحكم لا يتصور امتناع الحكم فيه بمانع، فلو كان الطريق ما قاله الخصم لاختص الاستثناء بالايجاب كدليل الخصوص ودليل الخصوص يختص بالايجاب.
والثاني أن الاستثناء إنما يصح إذا كان المستنثى بعض ما تناوله الكلام.
ولا يصح إذا كان جميع ما تناوله الكلام، ودليل الخصوص الذي هو رفع للحكم كالنسخ كما يعمل في البعض
يعمل في الكل، فعرفنا أنه ليس الطريق في الاستثناء ما ذهب إليه ولكن الطريق فيه أنه عبارة عما وراء المستثنى، حتى إذا كان يتوهم بعد الاستثناء بقاء شئ دون الخبر يجعل الكلام عبارة عنه صح، وإن لم يبق من الحكم شئ.
وبيان هذا أنه لو قال عبيدي أحرار إلا عبيدي لم يصح الاستثناء، ولو قال إلا هؤلاء وليس
له سواهم صح الاستثناء، لانه يتوهم بقاء شئ وراء المستثنى يجعل الكلام عبارة عنه هنا ولا توهم لمثله في الاول، وكذلك الطلاق على هذا.
ولا يجوز أن يقال إن استثناء الكل إنما لا يصح لانه رجوع، فإن فيما يصح الرجوع عنه لا يصح استثناء الكل أيضا، حتى إذا قال أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي كان الاستثناء باطلا والرجوع عن الوصية يصح، وإنما بطل الاستثناء هنا لانه لا يتوهم وراء المستثنى شئ يكون الكلام عبارة عنه، فعرفنا أنه تصرف في الكلام لا في الحكم، وأنه عبارة عما وراء المستثنى بأطول الطريقين تارة وأقصرهما تارة، والدليل عليه أن الدليل المعارض يستقل بنفسه والاستثناء لا يستقل بنفسه، فإنه ما لم يسبق صدر الكلام لا يتحقق الاستثناء مفيدا شيئا بمنزلة الغاية التي لا تستقل بنفسها.
فأما دليل الخصوص يصير مستقلا بنفسه وإن لم يسبقه الكلام ويكون مفيدا لحكمه.
ثم الدليل على صحة ما قال علماؤنا أن الاستثناء يبين أن صدر الكلام لم يتناول المستثنى أصلا فإنه تصرف في الكلام كما أن دليل الخصوص تصرف في حكم الكلام، ثم يتبين بدليل الخصوص أن العام لم يكن موجبا الحكم في موضع الخصوص فكذلك بالاستثناء يتبين أن أصل الكلام لم يكن متناولا للمستثنى.
والدليل على تصحيح هذه القاعدة قوله تعالى: (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) فإن معناه لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما، لان الالف اسم لعدد معلوم ليس فيه احتمال ما دونه بوجه فلو لم يجعل أصل الكلام هكذا لم يمكن تصحيح ذكر الالف بوجه لان اسم الالف لا ينطلق على تسعمائة وخمسين أصلا، وإذا قال الرجل لفلان علي ألف درهم إلا مائة فإنه يجعل كأنه قال له علي تسعمائة فإن مع بقاء صدر الكلام على حاله وهو الالف لا يمكن إيجاب
تسعمائة عليه ابتداء، لان القدر الذي يجب حكم صدر الكلام وإذا لم يكن في صدر
الكلام احتمال هذا المقدار لا يمكن إيجابه حقيقة، فعرفنا به أنه يصير صدر الكلام عبارة عما وراء المستثنى وهو تسعمائة، وكان لهذا العدد عبارتان الاقصر وهو تسعمائة والاطول هو الالف إلا مائة.
وهذا معنى قول أهل اللغة: إن الاستثناء استخراج، يعني استخراج بعض الكلام على أن يجعل الكلام عبارة عما وراء المستثنى، ألا ترى أن بعد دليل الخصوص الحكم الثابت بالعام ما يتناوله لفظ العموم حقيقة، حتى إذا كان العام بعبارة الفرد يجوز فيه الخصوص إلى أن لا يبقى منه إلا واحد، وإذا كان بلفظ الجمع يجوز فيه الخصوص إلى أن لا يبقى منه إلا ثلاثة، فإن أدنى ما تناوله اسم الجمع ثلاثة، وإذا كان الباقي دون ذلك كان رفعا للحكم بطريق النسخ.
ثم كما يجوز أن يكون الكلام معتبرا في الحكم ويمتنع ثبوت الحكم به لمانع فكذلك يجوز أن تبقى صورة الكلام، ولا يكون معتبرا في حق الحكم أصلا كطلاق الصبي والمجنون، فإذا جعلنا طريق الاستثناء ما ذهبنا إليه بقي صورة التكلم في المستثنى غير موجب بحكمه وذلك جائز، وإذا جعلنا الطريق ما قاله الخصم احتجنا إلى أن نثبت بالكلام ما ليس من محتملاته وذلك لا يجوز، فعرفنا أن انعدام وجوب المائة عليه لانعدام العلة الموجبة لا لمعارض يمنع الوجوب بعد وجود العلة الموجبة، وكذلك في التعليق بالشرط فإن امتناع ثبوت الحكم في المحل لانعدام علته بطريق أن التعليق بالشرط لما منع الوصول إلى المحل، وصورة التكلم بدون المحل لا يكون علة للايجاب، فانعدام الحكم لانعدام العلة في الفصلين لا لمانع كما توهمه الخصم إلا أن الوصول إلى المحل في التعليق متوهم لوجود الشرط فلم يبطل الكلام في حق الحكم أصلا، ولكن نجعله تصرفا آخر وهو اليمين على أنه متى وصل إلى المحل ولم يبق يمينا كان إيجابا، فسميناه بيان التبديل لهذا، وانتفاء المستثنى من أصل الكلام ليس فيه توهم الارتفاع حتى تكون صورة الكلام عاملا فيه، فجعلناه بيان التغيير بطريق أنه عبارة عما وراء المستثنى، لانه لم يصر تصرفا آخر
بالاستثناء، وهذا لان الكلمة كما لا تكون مفهمة قبل انضمام بعض حروفها إلى البعض لا تكون مفهمة قبل انضمام بعض الكلمات إلى البعض، حتى تكون دالة على المراد، فتوقف أول الكلام على آخره في الفصلين ويكون الكل في حكم كلام واحد، فإن ظهر باعتبار آخره لصدر الكلام محل آخر وهو الذمة، كما في الشرط، جعل بيانا فيه تبديل، وإن لم يظهر لصدر الكلام محل آخر بآخره جعل آخره مغيرا لصدره بطريق البيان، وذلك بالاستثناء، على أن يجعل عبارة عما وراء المستثنى، ويجعل بمنزلة الغاية على معنى أنه ينتهي به صدر الكلام ولولاه لكان مجاوزا إليه، كما أن بالغاية ينتهي أصل الكلام على معنى أنه لولا الغاية لكان الكلام متناولا له، ثم انعدام الحكم بعد الغاية لعدم الدليل المثبت لا لمانع بعد وجود المثبت، فكذلك انعدام الحكم في المستثنى لعدم دليل الموجب لا لمعارض مانع.
فأما قول أهل اللغة الاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفي، فإطلاق ذلك باعتبار نوع من المجاز، فإنهم كما قالوا هذا فقد قالوا إنه استخراج وإنه عبارة عما وراء المستثنى ولا بد من الجمع بين الكلمتين، ولا طريق للجمع سوى ما بينا وهو أنه باعتبار حقيقته في أصل الوضع عبارة عما وراء المستثنى، وهو نفي من الاثبات وإثبات من النفي باعتبار إشارته على معنى أن حكم الاثبات يتوقت به كما يتوقت بالغاية فإذا لم يبق بعده ظهر النفي لانعدام علة الاثبات فسمي نفيا مجازا.
فإن قيل: هذا فاسد فإن قول القائل لا عالم إلا زيد يفهم منه الاخبار بأن زيدا عالم، وكذلك كلمة الشهادة تكون إقرارا بالتوحيد حقيقة كيف يستقيم حمل ذلك على نوع من المجاز ؟ قلنا: قول القائل لا عالم نفي لوصف العلم وقوله إلا زيد توقيت للوصف به ومقتضى التوقيت انعدام ذلك الوصف بعد الوقت، فمقتضى كلامه هنا نفي صفة العلم لغير زيد ثم ثبت به العلم لزيد بإشارة كلامه لا بنص كلامه، كما أن نفي
النهار يتوقت إلى طلوع الفجر فبوجوده يثبت ما هو ضده وهو صفة النهار، ونفي السكون يتوقت بالحركة فبعد انعدام الحركة يثبت السكون، يقرره أن الآدمي لا يخلو عن أحد الوصفين إما العلم وإما نفي العلم عنه، فلما توقت النفي في صفة كلامه بزيد
ثبت صفة العلم فيه لانعدام ضده.
وفي كلمة الشهادة كذلك نقول، فإن كلامه نفي الالوهية عن غير الله تعالى ونفي الشركة في صفة الالوهية لغير الله معه، ثم يثبت التوحيد بطريق الاشارة إليه، وكان المقصود بهذه العبارة إظهار التصديق بالقلب فإنه هو الاصل والاقرار باللسان يبتنى عليه، ومعنى التصديق بالقلب بهذا الطريق يكون أظهر.
وعلى هذا الاصل قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله إذا قال إن خرجت من هذه الدار إلا أن يأذن لي فلان فمات فلان قبل أن يأذن له بطلت اليمين، كما لو قال إن خرجت من هذه الدار حتى يأذن لي فلان، لان في الموضعين يثبت باليمين حظر الخروج موقتا بإذن فلان، ولا تصور لذلك إلا في حال حياة فلان، فأما بعد موته وانقطاع إذنه لو بقيت اليمين كان موجبها حظرا مطلقا والموقت غير المطلق.
فإن قيل: أليس أنه لو قال لامرأته إن خرجت إلا بإذني فإنه يحتاج إلى تجديد الاذن في كل مرة، ولو كان الاستثناء بمنزلة الغاية لكانت اليمين ترتفع بالاذن مرة، كما لو قال إن خرجت من هذه الدار حتى آذن لك.
قلنا: إنما اختلفا في هذا الوجه لان كل واحد من الكلامين يتناول محلا آخر، فإن قوله حتى آذن محله الحظر الثابت باليمين فإنه توقيت له، وقوله إلا بإذني محله الخروج الذي هو مصدر كلامه ومعناه إلا خروجا بإذني، والخروج غير الحظر الثابت باليمين، فعرفنا أن كل واحد منهما دخل في محل آخر هنا، فلهذا كان حكم الاستثناء مخالفا لحكم التصريح بالغاية، وبالاستثناء يظهر معنى التوقيت في كل خروج يكون بصفة الاذن، وكل خروج لا يكون بتلك الصفة فهو موجب للحنث.
قال رضي الله عنه: اعلم بأن الاستثناء نوعان: حقيقة، ومجاز.
فمعنى الاستثناء حقيقة ما بينا، وما هو مجاز منه فهو الاستثناء المنقطع، وهي بمعنى لكن أو بمعنى العطف.
وبيانه في قوله تعالى: (لا يعلمون الكتاب إلا أماني) : أي لكن أباطيل.
قال تعالى: (فإنهم عدو لي إلا رب العالمين) : أي لكن رب العالمين الذي خلقني.
وقال: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما) : أي لكن سلاما.
وقيل في قوله تعالى: (إلا الذين ظلموا منهم) : إنه بمعنى العطف: ولا الذين ظلموا، وقيل لكن: أي لكن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني.
وقيل في قوله (إلا خطأ) : إنه
بمعنى لكن أي لكن إن قتله خطأ.
وزعم بعض مشايخنا أنه بمعنى ولا.
قال رضي عنه: وهذا غلط عندي، لانه حينئذ يكون عطفا على النهي فيكون نهيا والخطأ لا يكون منهيا عنه ولا مأمورا به بل هو موضوع، قال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) .
ثم الكلام لحقيقته لا يحمل على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة، كما في قوله تعالى: (إلا أن يعفون) فإنه يتعذر حمله على حقيقة الاستثناء لانه إذا حمل عليه كان في معنى التوقيت فيتقرر به حكم التنصيف الثابت بصدر الكلام، فعرفنا أنه بمعنى لكن وأنه ابتداء حكم: أي لكن إن عفا الزوج بإيفاء الكل أو المرأة بالاسقاط فهو أقرب للتقوى.
وكذلك قوله تعالى: (إلا الذين تابوا) في آية القذف فإنه استثناء منقطع: أي لكن إن تابوا من قبل أن التائبين هم القاذفون.
فتعذر حمل اللفظ على حقيقة الاستثناء فإن الثابت لا يخرج من أن يكون قاذفا، وإن كان محمولا على حقيقة الاستثناء هو استثناء بعض الاحوال: أي وأولئك هم الفاسقون في جميع الاحوال إلا أن يتوبوا، فيكون هذا الاستثناء توقيتا بحال ما قبل التوبة فلا تبقى صفة الفسق بعد التوبة لانعدام الدليل الموجب لا لمعارض مانع كما توهمه الخصم.
وقوله: لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء استثناء لبعض الاحوال أيضا: أي لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا حالة التساوي في الكيل.
فيكون توقيتا للنهي بمنزلة الغاية ويثبت بهذا النص أن حكم الربا الحرمة الموقتة في المحل دون المطلقة.
وإنما تتحقق الحرمة الموقتة في المحل الذي يقبل المساواة في الكيل، فأما في المحل الذي لا يقبل المساواة لو ثبت إنما يثبت حرمة مطلقة وذلك ليس من حكم هذا النص، فلهذا لا يثبت حكم الربا في القليل وفي المطعوم الذي لا يكون مكيلا أصلا.
وعلى هذا قلنا إذا قال لفلان علي ألف درهم إلا ثوبا فإنه تلزمه الالف لان هذا ليس
باستثناء حقيقة، إذ حقيقة الاستثناء في أصل الوضع أن يكون الكلام عبارة عما وراء المستثنى، والمستثنى هنا لم يتناوله صدر الكلام صورة ومعنى حتى يجعل الكلام عبارة عما وراءه فيكون استثناء منقطعا، ومعناه لكن لا ثوب له علي.
والتصريح بهذا الكلام لا يسقط عنه شيئا من الالف ولا يمنع إعمال أصل الكلام في إيجاب جميع الالف عليه فكذلك اللفظ الذي يدل عليه، ولهذا قال محمد في قوله إلا كر حنطة إنه تلزمه الالف كاملة.
فأما أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما استحسنا هنا فقالا: كلامه استثناء حقيقة باعتبار المعنى، لان صورة صدر الكلام الاخبار بوجوب المسمى عليه، ومعناه إظهار ما هو لازم في ذمته، والمكيل والموزون كشئ واحد في حكم الثبوت في الذمة على معنى أن كل واحد منهما يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا بمنزلة الاثمان، فهذا الاستثناء باعتبار صورة صدر الكلام لا يكون استخراجا، وباعتبار معناه يكون استخراجا، على أنه استخرج هذا القدر مما هو واجب في ذمته، والمعنى يترجح على الصورة لانه هو المطلوب، فلهذا جعلنا استثناءه استخراجا على أن يكون كلامه عبارة عما وراء مالية كر حنطة من الالف، فأما الثوب لا يكون مثل المكيل والموزون
في الصورة ولا في المعنى، وهو الثبوت في الذمة، فإنه لا يثبت في الذمة إلا مبيعا والالف تثبت في الذمة ثمنا فلا يمكن جعل كلامه استخراجا باعتبار الصورة ولا باعتبار المعنى، فلهذا جعلناه استثناء منقطعا.
ثم قال الشافعي بناء على أصله: الاستثناء متى تعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض ينصرف إلى جميع ما تقدم ذكره، لانه معارض مانع للحكم بمنزلة الشرط، ثم الشرط ينصرف إلى جميع ما سبق حتى يتعلق الكل به فكذلك الاستثناء.
واستدل عليه بقوله تعالى في آية قطاع الطريق: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) فإنه ينصرف إلى جميع ما تقدم ذكره.
وقال علماؤنا: الاستثناء تغيير وتصرف في الكلام فيقتصر على ما يليه خاصة
لوجهين: أحدهما أن إعمال الاستثناء باعتبار أن الكل في حكم كلام واحد وذلك لا يتحقق في الكلمات المعطوفة بعضها على بعض.
والثاني أن أصل الكلام عامل باعتبار أصل الوضع، وإنما انعدم هذا الوصف منه بطريق الضرورة فيقتصر على ما تتحقق فيه الضرورة وهذه الضرورة ترتفع بصرفه إلى ما يليه، بخلاف الشرط فإنه تبديل ولا يخرج به أصل الكلام من أن يكون عاملا إنما يتبدل به الحكم كما بينا، ومطلق العطف يقتضي الاشتراك فلهذا أثبتنا حكم التبديل بالتعليق بالشرط في جميع ما سبق ذكره مع أن فيه كلاما في الفرق بين ما إذا عطفت جملة تامة على جملة تامة وبين ما إذا عطفت جملة ناقصة على جملة تامة ثم تعقبها شرط، ولكن ليس هذا موضع بيان ذلك.
فأما قوله تعالى: (إلا الذين تابوا) فلاجل دليل في نص الكلام صرفناه إلى جميع ما تقدم وذلك التقييد بقوله تعالى: (من قبل أن تقدروا عليهم) فإن التوبة في محو الاثم ورجاء المغفرة والرحمة به في الآخرة لا تختلف بوجودها بعد قدرة الامام على التائب أو قبل ذلك، وإنما
تختلف في حكم إقامة الحد، الذي يكون مفوضا إلى الامام، فعرفنا بهذا التقييد أن المراد ما سبق من الحد، وقد يتغير حكم مقتضى الكلام لدليل فيه، ألا ترى أن مقتضى مطلق الكلام الترتيب على أن يجعل المتقدم في الذكر متقدما في الحكم، ثم يتغير ذلك بدليل مغير، كما في قوله تعالى: (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما) فإن المراد أنزله قيما ولم يجعل له عوجا.
وكذلك في قوله تعالى: (ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى) فإن معناه: ولولا سبقت من ربك كلمة وأجل مسمى لكان لزاما، وضمة اللام دلنا على ذلك فهذا نظيره.
وإذا تقرر هذا الاصل قلنا: البيان المغير والمبدل يصح موصولا ولا يصح مفصولا، لانه متى كان بيانا كان مقررا للحكم الثابت بصدر الكلام كبيان التقرير وبيان التفسير، وإنما يتحقق ذلك إذا كان موصولا، فأما إذا كان مفصولا فإنه يكون رفعا للحكم الثابت بمطلق الكلام.
أما في الاستثناء فإن الكلام يتم موجبا لحكمه بآخره وذلك بالسكوت عنه أو الانتقال إلى كلام آخر،
والاستثناء الموصول ليس بكلام آخر فإنه غير مستقل بنفسه، فأما إذا سكت فقد تم الكلام موجبا لحكمه، ثم الاستثناء بعد ذلك يكون نسخا بطريق رفع الحكم الثابت فلا يكون بيانا مغيرا، وأما الشرط فهو مبدل باعتبار أنه يمتنع الوصول إلى المحل وهو العبد في كلمة الاعتاق ويجعل محله الذمة، وإنما يتحقق هذا إذا كان موصولا، فأما المفصول يكون رفعا عن المحل يعتبر هذا في المحسوسات، فإن تعليق القنديل بالحبل في الابتداء يكون مانعا من الوصول إلى مقره من الارض مبينا أن إزالة اليد عنه لم يكن كسرا، فأما بعد ما وصل إلى مقره من الارض تعليقه بالقنديل يكون رفعا عن محله.
فتبين بهذا أن الشرط إذا كان مفصولا
فإنه يكون رفعا للحكم عن محله بمنزلة النسخ، وهو لا يملك رفع الطلاق والعتاق عن المحل بعدما استقر فيه، فلهذا لا يعمل الاستثناء والشرط مفصولا.
وعلى هذا قلنا: إذا قال لفلان علي ألف درهم وديعة فإنه يصدق موصولا ولا يصدق إذا قاله مفصولا، لان قوله وديعة بيان فيه تغيير أو تبديل، فإن مقتضى قوله علي ألف درهم الاخبار بوجوب الالف في ذمته، وقوله وديعة فيه بيان أن الواجب في ذمته حفظها وإمساكها إلى أن يؤديها إلى صاحبها لا أصل المال، فإما أن يكون تبديلا للمحل الذي أخبر بصدر الكلام أنه التزمه لصاحبه أو تغييرا لما اقتضاه أول الكلام، لانه لازم عليه للمقر له من أصل المال إلى الحفظ، فإذا كان موصولا كان بيانا صحيحا، وإذا كان مفصولا كان نسخا فيكون بمنزلة الرجوع عما أقر به.
وعلى هذا لو قال لغيره أقرضتني عشرة دراهم أو اسلفتني أو أسلمت إلي أو أعطيتني إلا أني لم أقبض فإن قال ذلك مفصولا لم يصدق، وإن قال موصولا صدق استحسانا، لان هذا بيان تغيير، فإن حقيقة هذه الالفاظ تقتضي تسليم المال إليه ولا يكون ذلك إلا بقبضه، إلا أنه يحتمل أن يكون المراد به العقد مجازا، فقد تستعمل هذه الالفاظ للعقد، فكان قوله لم أقبض تغييرا للكلام عن الحقيقة إلى المجاز فيصح موصولا ولا يصح مفصولا.
وإذا قال دفعت إلي ألف درهم أو نقدتني إلا أني لم أقبض فكذلك الجواب عند محمد، لان الدفع والنقد والاعطاء
في المعنى سواء، فتجعل هاتان الكلمتان كقوله أعطيتني ويصدق فيهما إذا كان موصولا لا إذا كان مفصولا بطريق أنه بيان تغيير.
وأبو يوسف قال فيهما لا يصدق موصولا ولا مفصولا، لان الدفع والنقد اسم للفعل لا يتناول العقد مجازا ولا حقيقة، فكان قوله إلا أني لم أقبض رجوعا والرجوع لا يعمل موصولا ولا مفصولا، فأما الاعطاء قد سمي به العقد مجازا، يقال عقد الهبة وعقد العطية.
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا قال لفلان علي ألف درهم إلا أنها زيوف لم يصدق موصولا ولا مفصولا.
وقال أبو يوسف ومحمد: يصدق موصولا لان قوله إلا أنها زيوف بيان تغيير، فإن مطلق تسمية الالف في البيع ينصرف إلى الجياد، لانه هو النقد الغالب وبه المعاملة بين الناس وفيه احتمال الزيوف بدون هذه العادة، فكان كلامه بيان تغيير فيصح موصولا لا مفصولا، كما في قوله إلا أنها وزن خمسة وكما في الفصول المتقدمة بل أولى، فإن ذلك نوع من المجاز وهذا حقيقة لان إسم الدراهم للزيوف حقيقة كما أنها للجياد حقيقة.
وأبو حنيفة يقول: مقتضى عقد المعاوضة وجوب المال بصفة السلامة، والزيافة في الدراهم عيب لان الزيافة إنما تكون بغش في الدراهم والغش عيب، فكان هذا رجوعا عن مقتضى أول كلامه والرجوع لا يعمل موصولا ولا مفصولا، وصار دعوى العيب في الثمن كدعوى العيب في البيع، بأن قال: بعتك هذه الجارية معيبا بعيب كذا، وقال المشتري بل اشتريتها سليمة، فإن البائع لا يصدق سواء قاله موصولا أو مفصولا، بخلاف قوله إلا أنها وزن خمسة فإن ذلك استثناء لبعض المقدار بمنزلة قوله إلا مائتين، وبخلاف قوله لفلان علي كر حنطة من ثمن بيع إلا أنها ردية لان الرداءة ليست بعيب في الحنطة، فالعيب ما يخلو عنه أصل الفطرة والرداءة في الحنطة تكون بأصل الخلقة، فكان هذا بيان النوع لا بيان العيب فيصح موصولا كان أو مفصولا.
وعلى هذا لو قال لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر، فإن عند أبي يوسف ومحمد هذا بيان تغيير من حقيقة وجوب المال إلى (بيان) مباشرة سبب الالتزام صورة وهو شراء الخمر فيصح موصولا لا مفصولا.
وأبو حنيفة يقول هذا رجوع، لان
أول كلامه تنصيص على وجوب المال في ذمته وثمن الخمر لا يكون واجبا في ذمة المسلم بالشراء فيكون رجوعا.
وعلى هذا لو قال لفلان علي ألف درهم من ثمن جارية
باعنيها إلا أني لم أقبضها فإن على قول أبي يوسف ومحمد يصدق إذا كان موصولا، وإذا كان مفصولا يسأل المقر له عن الجهة فإن قال الالف لي عليه بجهة أخرى سوى البيع فالقول قوله والمال لازم على المقر، وإن قال بجهة البيع ولكنه قبضها فالقول حينئذ قول المقر أنه لم يقبضها لان هذا بيان تغيير، فإنه يتأخر به حق المقر له في المطالبة بالالف إلى أن يحضر الجارية ليسلمها بمنزلة شرط الخيار أو الاجل في العقد يكون مغير لمقتضى مطلق العقد، ولا يكون ناسخا لاصله فيصح هذا البيان منه موصولا، وإذا كان مفصولا فإن صدقه في الجهة فقد ثبتت الجهة بتصادقهما عليه، ثم ليس في إقراره بالشراء ووجوب المال عليه بالعقد إقرار بالقبض فكان المقر له مدعيا عليه ابتداء تسليم المبيع، وهو منكر ليس براجع عما أقر به فجعلنا القول قول المنكر، وإذا كذبه في الجهة لم تثبت الجهة التي ادعاها وقد صح تصديقه له في وجوب المال عليه، وبيانه الذي قال إنه من ثمن جارية لم يقبضها بيان تغيير فلا يصح مفصولا.
وأبو حنيفة يقول هذا رجوع عما أقر به، لانه أقر بأول كلامه أن المال واجب له دينا في ذمته، وثمن جارية لا يوقف على أثرها لا تكون واجبة عليه إلا بعد القبض، فإن المبيعة قبل التسليم إذا صارت بحيث لا يوقف على عينها بحال بطل العقد ولا يكون ثمنها واجبا.
وقوله من ثمن جارية باعنيها ولكني لم أقبضها إشارة إلى هذا، فإن الجارية التي هي غير معينة لا يوقف على أثرها، وما من جارية يحضرها البائع إلا وللمشتري أن يقول المبيعة غيرها، فعرفنا أن آخر كلامه رجوع عما أقر به من وجوب المال دينا في ذمته، والرجوع لا يصح موصولا ولا مفصولا.
وعلى هذا قال أصحابنا في كتاب الشركة: إذا قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف درهم إلا نصفه فإنه يجعل هذا بيعا لنصف العبد بجميع الالف، ولو قال علي أن لي نصفه يكون بائعا نصف العبد بخمسمائة، لانه إذا قيد كلامه بالاستثناء يصير عبارة عما وراء المستثنى وإنما أدخله على المبيع
دون الثمن، وما وراء المستثنى من المبيع نصف العبد فيصير بائعا لذلك بجميع الالف.
فأما قوله على أن لي نصفه فهو معارض بحكمه لصدر الكلام ويصير بائعا جميع العبد من نفسه ومن المشتري بالالف وبيعه من نفسه معتبر إذا كان مفيدا، ألا ترى أن المضارب يبيع مال المضاربة من رب المال فيجوز لكونه مفيدا، وإذا كان كل واحد من البدلين مملوكا له فهنا أيضا إيجابه لنفسه مفيد في حق تقسيم الثمن فيعتبر ويتبين به أنه صار بائعا نصفه من المشتري بنصف الالف، كما لو باع منه عبدين بألف درهم وأحدهما مملوك له يصير بائعا عبد نفسه منه بحصته من الثمن إذا قسم على قيمته وقيمة العبد الذي هو ملك المشتري.
وعلى هذا الاصل قال أبو يوسف فيمن أودع صبيا محجورا عليه مالا فاستهلكه إنه يكون ضامنا، لان تسليطه إياه على المال بإثبات يده عليه يتنوع نوعين استحفاظ وغير استحفاظ، فيكون قوله أحفظه بيانا منه لنوع ما كان من جهته وهو التمكين، وبيانه تصرف منه في حق نفسه مقصورا عليه غير متناول لحق الغير، فينعدم ما سوى الاستحفاظ لانعدام علته، وينعدم نفوذ الاستحفاظ لانعدام ولايته على المحل وكون الصبي ممن لا يحفظ، وبعد انعدام النوعين يصير كأنه لم يوجد تمكينه من المال أصلا فإذا استهلكه كان ضامنا، كما لو كان المال في يد صاحبه على حاله فجاء الصبي واستهلكه.
وأبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما قالا: التسليط فعل مطلق وليس بعام حتى يصار فيه إلى التنويع، وقوله احفظ كلام ليس من جنس الفعل ليشتغل بتصحيحه بطريق الاستثناء ولكنه معارض، لان الدفع إليه تسليط مطلقا، وقوله احفظ معارض بمنزلة دليل الخصوص أو بمنزلة ما قاله الخصم في الاستثناء، وإنما يكون معارضا إذا صح منه هذا القول شرعا كدليل الخصوص إنما يكون معارضا إذا صح شرعا، ولا خلاف أن قوله احفظ
غير صحيح في حكم الاستحفاظ شرعا فيبقى التسليط مطلقا، فالاستهلاك بعد تسليط من له الحق مطلقا لا يكون موجبا للضمان على الصبي ولا على البالغ.
وما يخرج من المسائل على هذا الاصل يكثر تعدادها، فمن فهم ما أشرنا إليه فهو يهديه إلى ما سواها، والله أعلم.
فصل وأما بيان الضرورة فهو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في الاصل.
وهو على أربعة أوجه: منه ما ينزل منزلة المنصوص عليه في البيان، ومنه ما يكون بيانا بدلالة حال المتكلم، ومنه ما يكون بيانا بضرورة دفع الغرور، ومنه ما يكون بيانا بدلالة الكلام.
فأما الاول فنحو قوله: (وورثه أبواه فلامه الثلث) فإنه لما أضاف الميراث إليهما في صدر الكلام ثم بين نصيب الام كان ذلك بيانا أن للاب ما بقي فلا يحصل هذا البيان بترك التنصيص على نصيب الاب، بل بدلالة صدر الكلام يصير نصيب الاب كالمنصوص عليه.
وعلى هذا قال أصحابنا في المضاربة: إذا بين رب المال حصة المضارب من الربح ولم يبين حصة نفسه جاز العقد قياسا واستحسانا، لان المضارب هو الذي يستحق بالشرط وإنما الحاجة إلى بيان نصيبه خاصة وقد وجد، ولو بين نصيب نفسه من الربح ولم يبين نصيب المضارب جاز العقد استحسانا، لان مقتضى المضاربة الشركة بينهما في الربح فببيان نصيب أحدهما يصير نصيب الآخر معلوما ويجعل ذلك كالمنطوق به فكأنه قال ولك ما بقي.
وكذلك في المزارعة إذا بين نصيب من البذر من قبله ولم يبين نصيب الآخر جاز العقد استحسانا لهذا المعنى.
وكذلك لو قال في وصيته أوصيت لفلان وفلان بألف درهم لفلان منها أربعمائة، فإن ذلك بيان أن للآخر ستمائة بمنزلة ما لو نص عليه.
وكذلك لو قال أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو
لزيد من ذلك ألف درهم فإنه يجعل هذا بيانا منه أن ما يبقى من الثلث لعمرو كما لو نص عليه.
وأما النوع الثاني فنحو سكوت صاحب الشرع عن معاينة شئ عن تغييره يكون بيانا منه لحقيته باعتبار حاله، فإن البيان واجب عند الحاجة إلى البيان، فلو كان الحكم بخلافه لبين ذلك لا محالة ولو بينه لظهر، وكذلك سكوت الصحابة عن بيان قيمة الخدمة للمستحق على المغرور يكون دليلا على نفيه بدلالة حالهم،
لان المستحق جاء يطلب حكم الحادثة وهو جاهل بما هو واجب له، وكانت هذه أول حادثة وقعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعوا فيه نصا عنه، فكان يجب عليهم البيان بصفة الكمال، والسكوت بعد وجوب البيان دليل النفي.
وعلى هذا قلنا: إذا ولدت أمة الرجل ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فقال: الاكبر ابني، فإنه يكون ذلك بيانا منه أن الآخرين ليسا بولدين له، لان نفي نسب ولد ليس منه واجب، ودعوى نسب ولد هو منه ليتأكد به على وجه لا ينتفي واجب أيضا، فالسكوت عن البيان بعد تحقق الوجوب دليل النفي فيجعل ذلك كالتصريح بالنفي.
وعلى هذا قلنا: البكر إذا بلغها نكاح الولي فسكتت يجعل ذلك إجازة منها باعتبار حالها فإنها تستحي، فيجعل سكوتها دليلا على جواب يحول الحياء بينها وبين التكلم به وهو الاجازة التي يكون فيها إظهار الرغبة في الرجال، فإنها إنما تستحي من ذلك.
وأما النوع الثالث فنحو سكوت المولى عن النهي عند رؤية العبد يبيع ويشتري، فإنه يجعل إذنا له في التجارة لضرورة دفع الغرور عمن يعامل العبد، فإن في هذا الغرور إضرارا بهم والضرر مدفوع ولهذا لم يصح الحجر الخاص بعد الاذن العام المنتشر، والناس لا يتمكنون من استطلاع رأي المولى في كل معاملة يعاملونه
مع العبد، وإنما يتمكنون من التصرف بمرأى العين منه، ويستدلون بسكوته على رضاه، فجعلنا سكوته كالتصريح بالاذن لضرورة دفع الغرور.
وكذلك سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد العلم بالبيع يجعل بمنزلة إسقاط الشفعة لضرورة دفع الغرور عن المشتري، فإنه يحتاج إلى التصرف في المشتري، فإذا لم يجعل سكوت الشفيع عن طلب الشفعة إسقاطا للشفعة فإما أن يمتنع المشتري من التصرف أو ينقض الشفيع عليه تصرفه، فلدفع الضرر والغرور جعلنا ذلك كالتنصيص منه على إسقاط الشفعة، وإن كان السكوت في أصله غير موضوع للبيان بل هو ضده.
وكذلك نكول المدعى عليه عن اليمين يجعل بمنزلة الاقرار منه إما لدفع الضرر عن المدعي فيكون من النوع الثالث، أو لحال الناكل وهو امتناعه من اليمين المستحقة عليه بعد تمكنه من إيفائه.
وأما النوع الرابع فبيانه فيما إذا قال لفلان علي مائة ودرهم أو مائة ودينار، فإن ذلك بيان للمائة أنها من جنس المعطوف عندنا.
وعند الشافعي يلزمه المعطوف والقول في بيان جنس المائة قوله، وكذلك لو قال مائة وقفيز حنطة أو ذكر مكيلا أو موزونا آخر.
واحتج فقال: إنه أقر بمائة مجملا ثم عطف ما هو مفسر فيلزمه المفسر ويرجع إليه في بيان المجمل، كما لو قال مائة وثوب أو مائة وشاة أو مائة وعبد، وهذا لان المعطوف غير المعطوف عليه فلا يكون العطف تفسيرا للمعطوف عليه بعينه، وكيف يكون تفسيرا وهو في نفسه مقر به لازم إياه ! ولو كان تفسيرا له لم يجب به شئ لان الوجوب بالكلام المفسر لا بالتفسير.
ولكنا نقول: قوله ودرهم بيان للمائة عادة ودلالة.
أما من حيث العادة فلان الناس اعتادوا حذف ما هو تفسير عن المعطوف عليه في العدد إذا كان المعطوف مفسرا بنفسه كما اعتادوا حذف التفسير عن المعطوف عليه والاكتفاء بذكر التفسير للمعطوف،
فإنهم يقولون مائة وعشرة دراهم على أن يكون الكل من الدراهم، وإنما اعتادوا ذلك لضرورة طول الكلام وكثرة العدد والايجاز عند ذلك طريق معلوم عادة، وإنما اعتادوا هذا فيما يثبت في الذمة في عامة المعاملات كالمكيل والموزون دون ما لا يثبت في الذمة، إلا في معاملة خاصة كالثياب فإنها لا تثبت في الذمة قرضا ولا بيعا مطلقا، وإنما يثبت في السلم أو فيما هو في معنى السلم كالبيع بالثياب الموصوفة مؤجلا.
وأما من حيث الدلالة فلان المعطوف مع المعطوف عليه كشئ واحد من حيث الحكم والاعراب بمنزلة المضاف مع المضاف إليه، ثم الاضافة للتعريف حتى يصير المضاف معرفا بالمضاف إليه، فكذلك العطف متى كان صالحا للتعريف يصير المعطوف عليه معرفا بالمعطوف باعتبار أنهما كشئ واحد، ولكن هذا فيما يجوز أن يثبت في الذمة عند مباشرة السبب بذكر المعطوف بالمعطوف عليه كالمكيل والموزون.
فأما ما ليس بمقدر لا يثبت دينا في الذمة بذكر المعطوف (والمعطوف) عليه مع إلحاق التفسير بالمعطوف عليه، ولكن يحتاج إلى ذكر شرائط أخر، فلهذا لم نجعل المعطوف عليه مفسرا بالمعطوف هناك.
واتفقوا أنه لو قال لفلان علي مائة وثلاثة دراهم أنه تلزمه الكل من الدراهم.
وكذلك لو قال مائة وثلاثة أثواب أو ثلاثة أفراس أو ثلاثة أعبد، لانه عطف إحدى الجملتين على الاخرى ثم عقبهما بتفسير، والعطف للاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه، فالتفسير المذكور يكون تفسيرا لهما.
وكذلك لو قال له علي أحد وعشرون درهما فالكل دراهم، لانه عطف العدد المبهم على ما هو واحد مذكور على وجه الابهام، وقوله درهما مذكور على وجه التفسير فيكون تفسيرا لهما، والاختلاف في قوله له مائة ودرهمان كالاختلاف في قوله ودرهم.
وقد روي عن أبي يوسف أنه إذا قال له علي مائة وثوب أو مائة وشاة فالمعطوف يكون تفسيرا
للمعطوف عليه، بخلاف ما إذا قال مائة وعبد لان في قوله مائة ودرهم إنما جعلناه تفسيرا باعتبار أن المعطوف والمعطوف عليه كشئ واحد، وهذا يتحقق في كل ما يحتمل القسمة، فإن معنى الاتحاد بالعطف في مثله يتحقق، فأما ما لا يحتمل القسمة مطلقا كالعبد لا يتحقق فيه معنى الاتحاد بسبب العطف فلا يصير المجمل بالمعطوف فيه مفسرا، والله أعلم.
باب: النسخ جوازا وتفسيرا قال رضي الله عنه: اعلم بأن الناس تكلموا في معنى النسخ لغة فقال بعضهم: هو عبارة عن النقل، من قول القائل: نسخت الكتاب إذا نقله من موضع إلى موضع.
وقال بعضهم: هو عبارة عن الابطال، من قولهم نسخت الشمس الظل: أي أبطلته.
وقال بعضهم: هو عبارة عن الازالة من قولهم نسخت الرياح الآثار: أي أزالتها.
وكل ذلك مجاز لا حقيقة، فإن حقيقة النقل أن تحول عين الشئ من موضع إلى موضع آخر ونسخ الكتاب لا يكون بهذه الصفة إذ لا يتصور نقل عين المكتوب من موضع إلى موضع آخر وإنما يتصور إثبات مثله في المحل الآخر.
وكذلك في الاحكام فإنه لا يتصور نقل الحكم الذي هو منسوخ إلى ناسخه وإنما المراد إثبات مثله مشروعا في المستقبل أو نقل المتعبد من الحكم الاول إلى الحكم الثاني.
وكذلك معنى الازالة فإن إزالة الحجر عن مكانه لا يعدم عينه ولكن عينه باق في المكان الثاني، وبعد النسخ لا يبقى الحكم الاول، ولو كان حقيقة النسخ الازالة لكان يطلق هذا
اسم على كل ما توجد فيه الازالة وأحد لا يقول بذلك.
وكذلك لفظ الابطال فإن بالنص لا تبطل الآية وكيف تكون حقيقة النسخ الابطال وقد أطلق الله تعالى ذلك في الاثبات بقوله تعالى: (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) فعرفنا أن الاسم شرعي عرفناه بقوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) وأوجه
ما قيل فيه إنه عبارة عن التبديل من قول القائل نسخت الرسوم: أي بدلت برسوم أخر.
وقد استبعد هذا المعنى بعض من صنف في هذا الباب من مشايخنا وقال: في إطلاق لفظ التبديل إشارة إلى أنه رفع الحكم المنسوخ وإقامة الناسخ مقامه، وفي ذلك إيهام البداء والله تعالى يتعالى عن ذلك.
قال رضي الله عنه: وعندي أن هذا سهو منه وعبارة التبديل منصوص عليه في القرآن، قال تعالى: (وإذا بدلنا آية مكان آية) وإذا كان اسم النسخ شرعيا معلوما بالنص فجعله عبارة عما يكون معلوما بالنص أيضا يكون أولى الوجوه.
ثم هو في حق الشارع بيان محض، فإن الله تعالى عالم بحقائق الامور لا يعزب عنه مثقال ذرة، ثم إطلاق الامر بشئ يوهمنا بقاء ذلك على التأبيد من غير أن نقطع القول به في زمن من ينزل عليه الوحي، فكان النسخ بيانا لمدة الحكم المنسوخ في حق الشارع وتبديلا لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على ما كان معلوما عندنا لو لم ينزل الناسخ، بمنزلة القتل فإنه انتهاء الاجل في حق من هو عالم بعواقب الامور.
لان المقتول ميت بأجله بلا شبهة، ولكن في حق القاتل جعل فعله جناية على معنى أنه يعتبر في حقه حتى يستوجب به القصاص وإن كان ذلك موتا بالاجل المنصوص عليه في قوله تعالى: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) ومن فهم معنى التبديل بهذه الصفة عرف أنه ليس فيه من إيهام البداء شئ.
ثم المذهب عند المسلمين أن النسخ جائز في الامر والنهي الذي يجوز أن يكون ثابتا ويجوز أن لا يكون على ما نبينه في فصل محل النسخ، وعلى قول اليهود النسخ لا يجوز أصلا.
وهم في ذلك فريقان: فريق منهم يأبى النسخ عقلا، وفريق يأبى جوازه سمعا وتوقيفا.
وقد قال بعض من لا يعتد بقوله من المسلمين إنه لا يجوز النسخ أيضا، وربما قالوا لم يرد النسخ في شئ أصلا.
ولا وجه للقول الاول إذا كان القائل ممن يعتقد الاسلام، فإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها
من الشرائع فكيف يتحقق هذا القول منه مع اعتقاده لهذه الشريعة.
والثاني باطل نصا، فإن قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها) وقوله: (وإذا بدلنا آية مكان آية) نص قاطع على جواز النسخ، وانتساخ التوجه إلى بيت المقدس بفرضية التوجه إلى الكعبة أمر ظاهر لا ينكره عاقل، فقول من يقول لم يوجد باطل من هذا الوجه.
فأما من قال من اليهود إنه لا يجوز بطريق التوقيف استدل بما يروى عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والارض.
وزعموا أن هذا مكتوب في التوراة عندهم، وقالوا قد ثبت عندنا بالطريق الموجب للعلم وهو خبر التواتر عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شريعتي لا تنسخ كما تزعمون أنتم أن ذلك ثبت عندكم بالنقل المتواتر عمن تزعمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وبهذا الطريق طعنوا في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، وقالوا من أجل العمل في السبت لا يجوز تصديقه ولا يجوز أن يأتي بمعجزة تدل على صدقه.
ومن أنكر منهم ذلك عقلا قال الامر بالشئ دليل على حسن المأمور به، والنهي عن الشئ دليل على قبح المنهي عنه، والشئ الواحد لا يجوز أن يكون حسنا وقبيحا، فالقول بجواز النسخ قول بجواز البداء، وذلك إنما يتصور ممن يجهل عواقب الامور والله تعالى يتعالى عن ذلك، يوضحه أن مطلق الامر يقتضي التأبيد في الحكم وكذلك مطلق النهي، ولهذا حسن منا اعتقاد التأبيد فيه فيكون ذلك بمنزلة التصريح بالتأبيد، ولو ورد نص بأن العمل في السبت حرام عليكم أبدا لم يجز نسخه بعد ذلك بحال، فكذلك إذا ثبت التأبيد بمقتضى مطلق الامر إذ لو كان ذلك موقتا كما قلتم لكان تمام البيان فيه بالتنصيص على التوقيت، فما كان يحسن إطلاقه عن ذكر التوقيت وفي ذلك إيهام الخلل فيما بينه الله تعالى فلا يجوز القول به أصلا.
وحجتنا فيه من طريق التوقيف اتفاق الكل على أن جواز النكاح بين الاخوة والاخوات قد كان في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام، وبه حصل التناسل،
وقد انتسخ ذلك بعده، وكذلك جواز الاستمتاع بمن هو بعض من المرء قد كان في شريعته، فإن حواء رضي الله عنها خلقت منه وكان يستمتع بها ثم انتسخ ذلك الحكم حتى لا يجوز لاحد أن يستمتع بمن هو بعض منه بالنكاح نحو ابنته، ولان اليهود مقرون بأن يعقوب عليه السلام حرم شيئا من المطعومات على نفسه، وأن ذلك صار حراما عليهم كما أخبرنا الله تعالى به في قوله: (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) الآية، والنسخ ليس إلا تحريم المباح أو إباحة الحرام، وكذلك العمل في السبت كان مباحا قبل زمن موسى عليه السلام فإنهم يوافقوننا على أن حرمة العمل في السبت من شريعة موسى، وإنما يكون من شريعته إذا كان ثبوته بنزول الوحي عليه، فأما إذا كان ذلك قبل شريعته على هذا الوجه أيضا فلا فائدة في تخصيصه أنه شريعته، فإذا جاز ثبوت الحرمة في شريعته بعد ما كان مباحا جاز ثبوت الحل في شريعة نبي آخر قامت الدلالة على صحة نبوته.
ومن حيث المعقول الكلام من وجهين: أحدهما أن النسخ في المشروعات التي يجوز أن تكون مشروعا ويجوز أن لا تكون، ومعلوم أن هذه المشروعات شرعها الله تعالى على سبيل الابتلاء لعباده حتى يميز المطيع من العاصي.
ومعنى الابتلاء يختلف باختلاف أحوال الناس، وباختلاف الاوقات، فإن في هذا الابتلاء حكمة بالغة وليس ذلك إلا منفعة للعباد في ذلك عاجلا أو آجلا، لان الله تعالى يتعالى عن أن يلحقه المضار والمنافع، وما لا منفعة فيه أصلا يكون عبثا ضدا للحكمة، ثم قد تكون المنفعة في إثبات شئ في وقت وفي نفيه في وقت آخر كإيجاب الصوم في النهار إلى غروب الشمس أو طلوع النجوم كما هو مذهبهم، ونفي الصوم بعد
ذلك، ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس كوجوب اعتزال المرأة في حالة الحيض وانتفاء ذلك بعدما طهرت، ألا ترى أنه لو نص على ذكر الوقت فيه بأن قال حرمت عليكم العمل في السبت ألف سنة ثم هو مباح بعد ذلك كان مستقيما وكان معنى الابتلاء فيه متحققا ولم يكن فيه من معنى البداء شئ، فكذلك عند إطلاق اللفظ في التحريم.
ثم النسخ بعد ذلك إذا انتهت مدة التحريم الذي كان معلوما عند
الشارع حين شرعه لا يكون فيه من معنى البداء شئ بل يكون امتحانا للمخاطبين في الوقتين جميعا، وهو بمنزلة تبديل الصحة بالمرض والمرض بالصحة، وتبديل الغنى بالفقر والفقر بالغنى، فإن ذلك ابتلاء بالطريق الذي قلنا إليه أشار الله تعالى فيما أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: (إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه) والثاني أن النسخ بيان مدة بقاء الحكم وذلك غيب عنا لو بينه لنا في وقت الامر كان حسنا لا يشوبه من معنى القبح شئ فكذلك إذا بينه بعد ذلك بالنسخ.
وإنما قلنا ذلك لان النسخ إنما يكون فيما يجوز أن يكون مشروعا ويجوز أن لا يكون مشروعا ومع الشرع مطلقا يحتمل أن يكون موقتا ويحتمل أن يكون مؤبدا احتمالا على السواء، لان الامر يقتضي كونه مشروعا من غير أن يكون موجبا بقاءه مشروعا وإنما البقاء بعد الثبوت بدليل آخر سبق أو بعدم الدليل المزيل، فأما أن يكون ذلك واجبا بالامر فلا، لان إحياء الشريعة بالامر به كإحياء الشخص وذلك لا يوجب بقاءه وإنما يوجب وجوده، ثم البقاء بعد ذلك بإبقاء الله تعالى إياه أو بانعدام سبب الفناء، فكما أن الاماتة بعد الاحياء لا يكون فيه شئ من معنى القبح، ولا يكون دليل البداء والجهل بعواقب الامور بل يكون ذلك بيانا لمدة بقاء الحياة الذي كان معلوما عند الخالق حين خلقه، وإن كان ذلك غيبا عنا فكذلك النسخ في حكم الشرع.
فإن قيل: فعلى هذا بقاء الحكم قبل أن يظهر ناسخه لا يكون مقطوعا به لانه ما لم يكن هناك دليل موجب له لا يكون مقطوعا به، ولا دليل سوى الامر به.
قلنا: أما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك نقول بقاءه بعد الامر إنما يكون باستصحاب الحال لجواز نزول الوحي بما ينسخه ويبين به مدة بقائه إلا أن الواجب علينا التمسك بما ظهر عندنا لا بما هو غيب عنا، فما لم تظهر لنا مدة البقاء بنزول الناسخ يلزمنا العمل به، وكذلك بعد نزول الناسخ قبل أن يعلم المخاطب به.
وهو نظير حياة المفقود بعدما غاب عنا فإنه يكون ثابتا باستصحاب الحال لا بدليل موجب لبقائه حيا، ولكنا نجعله في حكم الاحياء بناء على ما ظهر لنا حتى يتبين انتهاء مدة حياته بظهور موته، فأما بعد وفاة الرسول عليه السلام
فلم يبق احتمال النسخ وصار البقاء ثابتا بدليل مقطوع به وهو أن النسخ لا يكون إلا على لسان من ينزل عليه الوحي، ولا توهم لذلك بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإن قيل: فعلى هذا لا يكون النسخ في أصل الامر لان الحكم الثابت بالامر غير الامر فببيان مدته لا يثبت تبديل الامر بالنهي.
قلنا: وهكذا نقول فإنه ليس في النسخ تعرض للامر بوجه من الوجوه بل للحكم الثابت به ظاهرا بناء على ما هو معلوم لنا، فإنه كان يجوز البقاء بعد هذه المدة باعتبار الاطلاق الذي كان عندنا.
فأما في حق الشارع فهو بيان مدة الحكم كما كان معلوما له حقيقة ولا يتحقق منه توهم التعرض للامر ولا لحكمه، كالاماتة بعد الاحياء، فإنه بيان المدة من غير أن يكون فيه تعرض لاصل الاحياء ولا لما يبتنى عليه من مدة البقاء، فاعتبار ما هو ظاهر لنا يكون فيه تبديل صفة الحياة بصفة الوفاة، وإنما تتحقق المنافاة بين القبح والحسن في محل واحد في وقت واحد، فأما في وقتين ومحلين فلا يتحقق ذلك، ألا ترى أنه
لا يتوجه الخطاب على من لا يعقل من صبي أو مجنون ثم يتوجه عليه الخطاب بعدما عقل، ويكون كل واحد منهما حسنا لاختلاف الوقت أو لاختلاف المحل.
وهذا لان أحوالنا تتبدل فيكون النسخ تبديلا بناء على ما يتبدل من أحوالنا من العلم مدة البقاء والجهل به لا يكون مؤديا إلى الجمع بين صفة القبح والحسن والله يتعالى عن ذلك، فكان في حقه بيانا محضا لمدة بقاء المشروع بمنزلة المنصوص عليه حين شرعه.
وما استدلوا به من السمع لا يكاد يصح عندنا بعدما ثبت رسالة رسل بعد موسى عليه السلام بالآيات المعجزة، والدلائل القاطعة.
ودعواهم أن ذلك في التوراة غير مسموعة منهم، لانه ثبت عندنا على لسان من ثبتت رسالته أنهم حرفوا التوراة وزادوا فيها ونقصوا، ولان كلام الله تعالى لا يثبت إلا بالنقل المتواتر وذلك لا يوجد في التوراة بعدما فعل بختنصر ببني إسرائيل ما فعل من القتل الذريع وإحراق أسفار التوراة.
وفي المسألة كلام كثير بين أهل الاصول، ولكنا اقتصرنا هنا على قدر ما يتصل بأصول الفقه، والمقصود من بيان هذه المسألة هنا ما يترتب عليها من أصول الفقه، والله الموفق للاتمام.
فصل: في بيان محل النسخ قد بينا أن جواز النسخ مختص بما يجوز أن يكون مشروعا ويجوز أن لا يكون مشروعا وهو مما يحتمل التوقيت نصا مع كونه مشروعا، لانه بيان مدة بقاء الحكم وبعد انتهاء المدة لا يبقى مشروعا فلا بد من أن يكون فيه احتمال الوصفين.
وبهذا البيان يظهر أنه إذا كان موقتا فلا بد من أن يكون محتملا للتوقيت نصا، وفي هذا بيان أنه ليس في أصل التوحيد احتمال النسخ بوجه من الوجوه، لان الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل كان ولا يزال يكون، ومن صفاته أنه صادق حكيم عالم بحقائق الامور فلا احتمال للنسخ في هذا بوجه من الوجوه، ألا ترى أن الامر بالايمان بالله
وكتبه ورسله لا يحتمل التوقيت بالنص، وأنه لا يجوز أن يكون غير مشروع بحال من الاحوال.
وعلى هذا قال جمهور العلماء لا نسخ في الاخبار أيضا، يعنون في معاني الاخبار واعتقاد كون المخبر به على ما أخبر به الصادق الحكيم، بخلاف ما يقوله بعض أهل الزيغ من احتمال النسخ في الاخبار التي تكون في المستقبل، لظاهر قوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) ولكنا نقول: الاخبار ثلاثة: خبر عن وجود ما هو ماض وذلك ليس فيه احتمال التوقيت ولا احتمال أن لا يكون موجودا، وخبر عما هو موجود في الحال وليس فيه هذا الاحتمال أيضا، وخبر عما هو كائن في المستقبل نحو الاخبار بقيام الساعة وليس فيه احتمال ما بينا من التردد، فتجويز النسخ في شئ من ذلك يكون قولا بتجويز الكذب والغلط على المخبر به، ألا ترى أنه لا يستقيم أن يقال اعتقدوا الصدق في هذا الخبر إلى وقت كذا ثم اعتقدوا فيه الكذب بعد ذلك.
والقول بجواز النسخ في معاني الاخبار يؤدي إلى هذا لا محالة، وهو البداء والجهل الذي تدعيه اليهود في أصل النسخ.
فأما قوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) فقد فسره الحسن رضي الله عنه بالاحياء والاماتة.
وفسره زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: (يمحو الله ما يشاء) مما أنزله من الوحي (ويثبت) بإنزال الوحي فيه.
فعلى هذا يتبين أن المراد ما يجوز أن يكون مؤقتا أو أن المراد التلاوة، ونحن نجوز ذلك في الاخبار أيضا بأن تترك التلاوة فيه حتى يندرس وينعدم حفظه من قلوب العباد كما في الكتب المتقدمة، وإنما
لا يجوز ذلك في معاني الاخبار على ما قررنا.
وإنما محل النسخ الاحكام المشروعة بالامر والنهي مما يجوز أن لا يكون مشروعا ويجوز أن يكون مشروعا موقتا.
وذلك ينقسم أربعة أقسام: قسم منه ما هو مؤبد بالنص، وقسم منه ما يثبت التأبيد فيه بدلالة النص، وقسم منه ما هو موقت بالنص.
فهذه الاقسام الثلاثة
ليس فيها احتمال النسخ أيضا، وإنما احتمال النسخ في القسم الرابع وهو المطلق الذي يحتمل أن يكون موقتا ويحتمل أن يكون مؤبدا احتمالا على السواء.
فأما بيان القسم الاول في قوله تعالى: (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة) ففيه تنصيص على التأبيد، وكذلك في قوله تعالى: (خالدين فيها أبدا) لان بعد التنصيص على التأبيد بيان التوقيت فيه بالنسخ لا يكون إلا على وجه البداء وظهور الغلط، والله تعالى يتعالى عن ذلك.
وما ثبت التأبيد فيه بدلالة النص فبيانه في الشرائع بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقرا عليها فإنه ليس فيها احتمال النسخ، لان النسخ لا يكون إلا على لسان من ينزل عليه الوحي، وقد ثبت بدليل مقطوع به أن رسول الله خاتم النبيين وأنه لا نسخ لشريعته فلا يبقى احتمال النسخ بعد هذه الدلالة فيما كان شريعة له حين قبض.
ونظيره من المخلوقات الدار الآخرة فقد ثبت بدليل مقطوع به أنه لا فناء لها.
وأما القسم الثالث: فبيانه في قول القائل: أذنت لك في أن تفعل كذا إلى مائة سنة، فإن النهي قبل مضي تلك المدة يكون من باب البداء، ويتبين به أن الاذن الاول كان غلطا منه لجهله بعاقبة الامر، والنسخ الذي يكون مؤديا إلى هذا لا يجوز القول به في أحكام الشرع، ولم يرد شرع بهذه الصفة.
فأما القسم الرابع: فبيانه في العبادات المفروضة شرعا عند أسباب جعلها الشرع سببا لذلك فإنها تحتمل التوقيت نصا يعني في الاداء اللازم باعتبار الامر، وفي الاسباب التي جعلها الله تعالى سببا لذلك، فإنه لو قال جعلت زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر عليكم إلى وقت كذا كان مستقيما، ولو قال جعلت شهود الشهر سببا لوجوب الصوم عليكم إلى وقت كذا كان مستقيما.
وهذا كله في الاصل مما يجوز أن يكون
مشروعا ويجوز أن لا يكون، فكان النسخ فيه بيانا لمدة بقاء الحكم وذلك جائز باعتبار ما بينا من المعنيين: أحدهما أن معنى الابتلاء والمنفعة للعباد في شئ يختلف باختلاف الاوقات واختلاف الناس في أحوالهم.
والثاني أن دليل الايجاب غير موجب للبقاء بمنزلة البيع يوجب الملك في المبيع للمشتري ولا يوجب بقاء الملك بل بقاؤه بدليل آخر مبق أو بعدم دليل المزيل وهو موجب الثمن في ذمة المشتري ولا يوجب بقاء الثمن في ذمته لا محالة، ولا يكون في النسخ تعرضا للامر ولا للحكم الذي هو موجبه، وامتناع جواز النسخ فيما تقدم من الاقسام كان لاجتماع معنى القبح والحسن، وإنما يتحقق ذلك في وقت واحد لا في وقتين، حتى إن ما يكون حسنا لعينه لا يجوز أن يكون قبيحا لعينه بوجه من الوجوه.
فإن قيل: أليس أن الخليل صلى الله عليه وسلم أمر بذبح ولده وكان الامر دليلا على حسن ذبحه ثم انتسخ ذلك فكان منهيا عن ذبحه مع قيام الامر حتى وجب ذبح الشاة فداء عنه، ولا شك أن النهي عن ذبح الولد الذي به يثبت الانتساخ كان دليلا على قبحه وقد قلتم باجتماعهما في وقت واحد.
قلنا: لا كذلك فإنا لا نقول بأنه انتسخ الحكم الذي كان ثابتا بالامر، وكيف يقال به وقد سماه الله محققا رؤياه بقوله تعالى: (وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) : أي حققت ما أمرت به.
وبعد النسخ لا يكون هو محققا ما أمر به، ولكنا نقول الشاة كانت فداء كما نص الله عليه في قوله: (وفديناه بذبح عظيم) على معنى أنه يقدم على الولد في قبول حكم الوجوب بعد أن كان الايجاب بالامر مضافا إلى الولد حقيقة، كمن يرمي سهما إلى غيره فيفديه آخر بنفسه بأن يتقدم عليه حتى ينفذ فيه بعد أن يكون خروج السهم من الرامي إلى المحل الذي قصده، وإذا كان فداء من هذا الوجه كان هو ممتثلا للحكم الثابت بالامر فلا يستقيم القول بالنسخ فيه، لان ذلك يبتنى على النهي الذي هو ضد الامر، فلا يتصور اجتماعهما في وقت واحد.
فإن قيل: فإيش الحكمة في إضافة الايجاب إلى الولد إذا لم يجب به ذبح الولد ؟ قلنا: فيه تحقيق معنى الابتلاء في حق الخليل عليه السلام حتى يظهر منه الانقياد والاستسلام والصبر على ما به من حرقة القلب على ولده، وفي حق الولد بالصبر والمجاهدة على معرة الذبح إلى حال المكاشفة.
وفيه إظهار معنى الكرامة والفضيلة
للخليل عليه السلام بالاسلام لرب العالمين، وللولد بأن يكون قربانا لله، وإليه أشار الله تعالى في قوله: (فلما أسلما) ثم استقر حكم الوجوب في الشاة بطريق الفداء للولد كما قال: (وفديناه بذبح عظيم) والفداء اسم لما يكون واجبا بالسبب الموجب للاصل فيه يتبين انعدام النسخ هنا لانعدام ركنه فإنه بيان مدة بقاء الواجب، وحين وجبت الشاة فداء كان الواجب قائما والولد حرام الذبح، فعرفنا أنه لا وجه للقول بأنه كان نسخا.
ثم على مذهب علمائنا يجوز نسخ الاخف بالاثقل كما يجوز نسخ الاثقل بالاخف.
وذكر الشافعي في كتاب الرسالة أن الله تعالى فرض فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة وتخفيفا لعباده، فزعم بعض أصحابه أنه أشار بهذا إلى وجه الحكمة في النسخ.
وقال بعضهم بل أراد به أن الناسخ أخف من المنسوخ وكان لا يجوز نسخ الاخف بالاثقل، واستدلوا فيه بقوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها) وبالاتفاق ليس المراد أن الناسخ أفضل من المنسوخ، فعرفنا أن المراد أنه خير من حيث إنه أخف، وعليه نص في موضع آخر فقال: (الآن خفف الله عنكم) الآية.
ولكنا نستدل بقوله: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) فالتقييد بكون الناسخ أخف من المنسوخ يكون زيادة على هذا النص من غير دليل، ثم المعنى الذي دل على جواز النسخ وهو ما أشرنا إليه من الابتلاء والنقل إلى ما فيه منفعة لنا عاجلا أو آجلا لا يفصل بينهما، فقد يكون المنفعة تارة في النقل إلى ما هو أخف على البدن، وتارة في النقل إلى ما هو أشق على البدن، ألا ترى أن الطبيب ينقل المريض من الغذاء إلى
الدواء تارة، ومن الدواء إلى الغذاء تارة بحسب ما يعلم من منفعته فيه.
ثم هو بيان مدة بقاء الحكم على وجه لو كان مقرونا بالامر لكان صحيحا مستقيما، وفي هذا لا فرق بين الاثقل والاخف، ولا حجة لهم في قوله: (الآن خفف الله عنكم) فإن النسخ في ذلك الحكم بعينه كان نقلا من الاثقل إلى الاخف، وهذا يدل على أن كل نسخ يكون بهذه الصفة، ألا ترى أن حد الزنا كان في الابتداء هو الحبس والاذى باللسان ثم انتسخ ذلك بالجلد والرجم.
ولا شك أن الناسخ أثقل على البدن.
وجاء عن معاذ وابن عمر رضي الله عنهم في قوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم) أن حكمه كان هو التخيير للصحيح بين الصوم والفدية ثم انتسخ ذلك بفرضية الصوم عزما بقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وانتسخ حكم إباحة الخمر بالتحريم وهو أشق على
البدن.
ثم لا شك أنه قد افترض على العباد بعض ما كان مشروعا لا بصفة الفرضية وإلزام ما كان مباحا يكون أشق لا محالة.
وبهذا يتبين أنه ليس المراد من قوله: (نأت بخير منها) الاخف على البدن، فإن الحج ما كان لازما قبل نزول قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت) وكان كل مسلم مندوبا إلى أدائه ثم صار الاداء لازما بهذه الآية وهذا أشق على البدن، يوضحه أن ترك الخروج للحج يكون أخف على البدن من الخروج، ولا إشكال أن الخروج إلى أداء الحج بعد التمكن خير من الترك.
فبهذا يتبين ضعف استدلالهم.
فصل: في بيان شرط النسخ قال رضي الله عنه: اعلم بأن شرط جواز النسخ عندنا هو التمكن من عقد القلب، فأما الفعل أو التمكن من الفعل فليس بشرط، وعلى قول المعتزلة التمكن من الفعل شرط.
وحاصل المسألة أن النسخ بيان لمدة عقد القلب والعمل بالبدن تارة، ولاحدهما وهو عقد القلب على الحكم تارة، فكان عقد القلب هو الحكم
الاصلي فيه، والعمل بالبدن زيادة يجوز أن يكون النسخ بيانا للمدة فيه ويجوز أن لا يكون عندنا.
وعلى قولهم النسخ يكون بيانا لمدة الحكم في حق العمل به وذلك لا يتحقق إلا بعد الفعل أو التمكن منه حكما، لان الترك بعد التمكن فيه تفريط من العبد فلا ينعدم به معنى بيان مدة العمل بالنسخ.
قالوا لان العمل هو المقصود بالامر والنهي، ألا ترى أن ورودهما بذكر الفعل معنى قول القائل افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا.
وتحقيق معنى الابتلاء في الفعل أيضا، فعرفنا أنه هو المقصود والنسخ قبل التمكن من الفعل لا يكون إلا بطريق البداء، ألا ترى أن الانسان يقول قد أمرت عبدي أن يفعل غدا كذا ثم بدا لي فنهيته عنه.
وهذا لانه إنما ينتهي عما أمر بفعله قبل التمكن من الفعل، بأن يظهر له من حال المأمور به ما لم يكن معلوما حين يأمره به لعلمنا أنه بالامر إنما طلب من المأمور إيجاد الفعل بعد التمكن منه لا قبله، إذ التكليف لا يكون إلا بحسب الوسع، والبداء على الله تعالى لا يجوز، يقرره أن القول بجواز النسخ قبل التمكن يؤدي إلى أن يكون الشئ الواحد حسنا وقبيحا في وقت واحد، لان الامر دليل على حسن فعل المأمور به عند الامكان، والنهي قبل التمكن
دليل على قبح فعله في ذلك الوقت بعينه، يوضحه أن النسخ بيان مدة بقاء الحكم على وجه يجوز أن يكون مقرونا بالامر، ولهذا جاز النسخ في الامر والنهي دون الخبر، والنسخ قبل التمكن لا يصح مقرونا بالامر، فإنه لا يستقيم أن يقول افعل كذا إلى أن لا يكون متمكنا منه ثم لا يفعله بعد ذلك، فعرفنا أن النسخ قبل التمكن لا يجوز.
وحجتنا في ذلك الحديث المشهور إن الله تعالى فرض على عباده خمسين صلاة في ليلة المعراج، ثم انتسخ ما زاد على الخمس لسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك نسخا قبل التمكن من الفعل إلا أنه كان بعد عقد القلب عليه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاصل لهذه الامة ولا شك أنه عقد قلبه على ذلك، ولا معنى لقولهم إن الله تعالى ما فرض ذلك عزما وإنما جعل ذلك إلى رأي رسوله ومشيئته،
لان في الحديث أن رسول الله عليه السلام سأل التخفيف عن أمته غير مرة وما زال يسأل ذلك ويجيبه ربه إليه حتى انتهى إلى الخمس، فقيل له: لو سألت التخفيف أيضا فقال: أنا أستحي من ربي وفي هذا بيان أنه لم يكن ذلك مفوضا إلى اختياره بل كان نسخا على وجه التخفيف بسؤاله بعد الفرضية.
ومنهم من استدل بقوله: (فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) إلى قوله (فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم) فإن هذا نسخ الامر قبل الفعل، ولكنهم يقولون كان هذا النسخ بعد التمكن من الفعل وإن كان قبل مباشرة الفعل ولا خلاف في جواز ذلك، والاصح هو الاول، ولان النسخ جائز بعد وجود جزء مما تناوله الامر بالفعل، فإن قول القائل افعلوا كذا في مستقبل أعماركم يجوز نسخه بالنهي عنه بعد مضي جزء من العمر، ولولا النسخ لكان أصل الكلام متناولا لجميع العمر، فبالنسخ يتبين أنه كان المراد الابتلاء بالعمل في ذلك الجزء خاصة ولا يتوهم فيه معنى البداء أو الجهل بعاقبة الامر، فكذلك النسخ بعد عقد القلب على الحكم، واعتقاد الحقية فيه قبل التمكن من العمل يكون بيانا أن المراد كان عقد القلب عليه إلى هذا الوقت واعتقاده الفرضية فيه دون مباشرة العمل، وإنما يكون مباشرة العمل مقصودا لمن ينتفع به، والله يتعالى عن ذلك، وإنما المقصود فيما يأمر الله به عباده الابتلاء، والابتلاء بعزيمة القلب
واعتقاد الحقية لا يكون دون الابتلاء بالعمل وربما يكون ذلك أهم، ألا ترى أن في المتشابه ما كان الابتلاء إلا بعقد القلب عليه واعتقاد الحقية فيه.
وكذلك في المجمل الذي لا يمكن العمل به إلا بعد البيان يكون الابتلاء قبل البيان بعقد القلب عليه واعتقاد الحقية فيه، ويكون ذلك حسنا لا يشوبه من معنى القبح شئ، فكذلك الامر الذي يرد النسخ عقيبه قبل التمكن من الفعل، ويعتبر هذا بإحياء الشخص، فقد تبين انتهاء مدة حياته بالموت قبل أن يصير منتفعا بحياته إما في بطن
أمه بأن ينفصل ميتا أو بعد الانفصال قبل أن ينتفع بحياته، وأحد لا يقول إنه يتمكن فيه معنى البداء أو إنه يجتمع فيه معنى الحسن والقبح، يوضحه أن الواحد منا قد يأمر عبده ومقصوده من ذلك أن يظهر عند الناس حسن طاعته وانقياده له ثم ينهاه عن ذلك بعد حصول هذا المقصود قبل أن يتمكن من مباشرة الفعل، ولا يجعل ذلك دليل البداء منه وإن كان ممن يجوز عليه البداء، فلان لا يجعل النسخ قبل التمكن من الفعل بعد عزم القلب واعتقاد الحقية موهما للبداء في حق من لا يجوز عليه البداء أولى، وإنما يجتمع الحسن والقبح في شئ واحد إذا كان مأمورا به ومنهيا عنه في وقت واحد، وذلك لا يكون، مع أن الحسن مطلقا ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، يقرره أن تمام الحسن على ما يزعمون إنما يظهر عند مباشرة العمل والاطلاق يقتضي صفة الكمال، ثم بالاتفاق يجوز النسخ بعد التمكن من الفعل قبل حقيقة الفعل، لان معنى الحسن فيه كامل من حيث عقد القلب واعتقاد الحقية فيه فكذلك قبل التمكن، ولا نقول بأن مثل هذا البيان لا يجوز مقرونا بالامر فإنه لو قال افعل كذا في وقت كذا (إن لم أنسخه عنك كان ذلك أمرا مستقيما بمنزلة قوله افعل كذا في وقت كذا) إن تمكنت منه، وتكون الفائدة في الحال هو القبول بالقلب واعتقاد الحقية فيه، فكذلك يجوز مثله بعد الامر بطريق النسخ، والله الموفق.
فصل: في بيان الناسخ قال رضي الله عنه: اعلم بأن الحجج أربعة: الكتاب، والسنة، والاجماع،
والقياس.
ولا خلاف بين جمهور العلماء في أنه لا يجوز نسخ الكتاب والسنة بالقياس، وكان ابن سريج من أصحاب الشافعي يجوز ذلك، والانماطي من أصحابه كان يقول لا يجوز ذلك بقياس الشبه ويجوز بقياس مستخرج من الاصول، وكل
قياس هو مستخرج من القرآن يجوز نسخ الكتاب به، وكل قياس هو مستخرج من السنة يجوز نسخ السنة به، لان هذا في الحقيقة نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، فثبوت الحكم بمثل هذا القياس في الحقيقة يكون محالا به على الكتاب والسنة.
وهذا قول باطل باتفاق الصحابة، فقد كانوا مجمعين على ترك الرأي بالكتاب والسنة، حتى قال عمر رضي الله عنه في حديث الجنين: كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ولكني رأيت رسول الله يمسح على ظاهر الخف دون باطنه.
ولان القياس كيفما كان لا يوجب العلم فكيف ينسخ به ما هو موجب للعلم قطعا، وقد بينا أن النسخ بيان مدة بقاء الحكم وكونه حسنا إلى ذلك الوقت، ولا مجال للرأي في معرفة انتهاء وقت الحسن، وما ادعاه من أن هذا الحكم يكون ثابتا بالكتاب فكلام ضعيف، فإن الوصف الذي به يرد الفرع إلى الاصل المنصوص عليه في الكتاب والسنة غير مقطوع بأنه هو المعنى في الحكم الثابت بالنص، وأحد من القائسين لا يقول بأن حكم الربا فيما عدا الاشياء الستة يكون ثابتا بالنص الذي فيه ذكر الاشياء الستة.
وأما النسخ بالاجماع فقد جوزه بعض مشايخنا بطريق أن الاجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به، والاجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، وإذا كان يجوز النسخ بالخبر المشهور كما أشرنا إليه في الزيادة على النص فجوازه بالاجماع أولى.
وأكثرهم على أنه لا يجوز ذلك، لان الاجماع عبارة عن اجتماع الآراء على شئ، وقد بينا أنه لا مجال للرأي في معرفة نهاية وقت الحسن والقبح في الشئ عند الله تعالى، ثم أوان النسخ حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتفاقنا على أنه لا نسخ بعده، وفي حال حياته ما كان ينعقد الاجماع بدون رأيه،
وكان الرجوع إليه فرضا، وإذا وجد البيان منه فالموجب للعلم قطعا هو البيان المسموع
منه، وإنما يكون الاجماع موجبا للعلم بعده ولا نسخ بعده، فعرفنا أن النسخ بدليل الاجماع لا يجوز.
ثم الاقسام بعد هذا أربعة: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ الكتاب بالسنة، ونسخ السنة بالكتاب.
ولا خلاف بين العلماء في جواز القسمين الاولين، ويختلفون في القسمين الآخرين.
فعندنا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة على ما ذكره الكرخي عن أبي يوسف أنه يجوز نسخ الكتاب بمثل خبر المسح على الخفين وهو مشهور، وكذلك يجوز نسخ السنة بالكتاب.
وعلى قول الشافعي لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب، فإنه قال في كتاب الرسالة: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة كما لا ينسخ الكتاب إلا الكتاب.
فمن أصحابه من يقول مراده نفي الجواز، ومنهم من يقول مراده نفي الوجود: أي لم يوجد في الشريعة نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب.
فيحتاج إلى إثبات الفصلين بالحجة.
فأما هو احتج بقوله تعالى: (قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي) وفي هذا تنصيص على أنه كان متبعا لكل ما يوحى إليه ولم يكن مبدلا لشئ منه والنسخ تبديل، قال تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) فأخبر أنه مبين لما هو المنزل حتى يعمل الناس بالمنزل بعدما تبين لهم ببيانه، وفي تجويز نسخ الكتاب بالسنة رفع هذا الحكم، لان العمل بالناسخ يكون، فإذا كان الناسخ من السنة لا يكون العمل به عملا بالمنزل.
وقوله تعالى: (ولعلهم يتفكرون) : أي يتفكرون في المنزل ليعملوا به بعد بيانه، وفي الناسخ في المنسوخ التفكر في التاريخ بينهما ليجعل المتقدم منسوخا بالمتأخر
لا في المنزل ليعمل به، وقال تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) ولا شك أن السنة لا تكون مثلا للقرآن ولا خيرا منه، والقرآن كلام الله غير محدث ولا مخلوق وهو معجز، والسنة كلام مخلوق وهو غير معجز.
فعرفنا أن نسخ الكتاب لا يجوز بالسنة، وقال عليه السلام: إذا روي لكم
عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالف كتاب الله فردوه ومع هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجوز نسخ الكتاب بالسنة ؟ ! ولان ما قلته أقرب إلى صيانة رسول الله عن طعن الطاعنين فيه، وبالاتفاق يجب المصير في باب بيان أحكام الشرع إلى طريق يكون أبعد عن الطعن فيه.
وبيان ذلك أنه إذا جاز منه أن يقول ما هو مخالف للمنزل في الظاهر على وجه النسخ له فالطاعن يقول هو أول قائل وأول عامل بخلاف ما يزعم أنه أنزل إليه فكيف يعتمد قوله فيه ! وإذا ظهر منه قول ثم قرأ ما هو مخالف لما ظهر منه من القول فالطاعن يقول قد كذبه ربه فيما قال فكيف نصدقه ؟ وإلى هذا أشار الله تعالى في قوله: (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر) ثم نفى عنه هذا الطعن بقوله: (قل نزله روح القدس من ربك بالحق) ففي هذا بيان أنه ليس في نسخ الكتاب بالكتاب تعريضه للطعن، وفي نسخ الكتاب بالسنة تعريضه للطعن من الوجه الذي قاله الطاعنون، فيجب سد هذا الباب لعلمنا أنه مصون عما يوهم الطعن فيه.
واستدل على نفي جواز نسخ (السنة) بالكتاب بقوله: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ) والسنة شئ فيكون الكتاب تبيانا لحكمه لا رافعا له، وذلك في أن يكون مؤيدا إن كان موافقا ومبينا للغلط فيها إن كان مخالفا، ولهذا لا يجوز إلا عند وروده ليكون بيانا محضا، فإن رسول الله كان لا يقر على الخطأ، والبيان المحض ما يكون مقارنا،
ولان النبي عليه السلام إذا أمر بشئ وتقرر ذلك فقد توجه علينا الامر من الله تعالى بتصديقه في ذلك واتباعه، فلا يجوز القول بأن ينزل في القرآن بعد ذلك ما يكون مخالفا له حقيقة أو ظاهرا، فإن ذلك يؤدي إلى القول بأنه لا يفترض تصديقه فيما يخبر به لجواز أن ينزل القرآن بخلافه وذلك خلاف النص وخلاف قول المسلمين أجمع، يقرره أن السنة نوع حجة لاثبات حكم الشرع، والكتاب كذلك، وحجج الشرع لا تتناقض وإنما يتأيد نوع منها بنوع
آخر، لان في التناقض ما يؤدي إلى تنفير الناس عن قبوله، وما يستدل به على أنه من عند غير الله، قال تعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فبهذا يتبين أن أحد النوعين يتأيد بالآخر، ولا يتمكن فيما بين النوعين تناقض، والقول بجواز نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة يؤدي إلى هذا.
وحجتنا في ذلك من أصحابنا من استدل بقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين) ففي هذا تنصيص على أن الوصية للوالدين والاقربين فرض ثم انتسخ ذلك بقوله عليه السلام: لا وصية لوارث وهذه سنة مشهورة.
ولا يجوز أن يقال إنما انتسخ ذلك بآية المواريث لان فيها إيجاب حق آخر لهم بطريق الارث وإيجاب حق بطريق الارث لا ينافي حقا آخر ثابتا بطريق آخر، وبدون المنافاة لا يثبت النسخ.
ولا يجوز أن يقال لعل ناسخه مما أنزل في القرآن ولكن لم يبلغنا لانتساخ تلاوته مع بقاء حكمه، لان فتح هذا الباب يؤدي إلى القول بالوقف في جميع أحكام الشرع، فإنه يقال: ما من حكم إلا ويتوهم فيه أن يكون ناسخه قد نزل ثم لم يبلغنا لانتساخ تلاوته، ومع ذلك يؤدي هذا إلى مذهب الروافض، فإنهم يقولون قد نزلت آيات كثيرة
فيها تنصيص على إمامة علي ولم يبلغنا ذلك، ويقولون إن لظاهر ما نزل من القرآن باطنا لا نعقله وقد كان يعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فيزعمون أن كثيرا من الاحكام قد خفي علينا ويجب الرجوع فيها إلى أهل البيت للوقوف على ذلك، وقد أجمع المسلمون على بطلان القول بهذا، فكل سؤال يؤدي إلى القول بذلك فهو ساقط.
ولكن هذا الاستدلال مع هذا ليس بقوي من وجهين: أحدهما أن في آية المواريث تنصيصا على ترتيب الارث على وصية منكرة، فإنه قال: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) والتي كانت مفروضة من الوصية هي الوصية المعهودة المعرفة بالالف واللام، فإنه قال: (الوصية للوالدين) فلو كانت تلك الوصية باقية عند نزول آية المواريث لكان فيها ترتيب الميراث على الوصية المعهودة، وفي التنصيص على ترتيب الارث على
وصية مطلقة دليل نسخ الوصية المعهودة، لان الاطلاق بعد التقييد نسخ كما أن التقييد بعد الاطلاق نسخ.
والثاني أن النسخ في الشرع نوعان: أحدهما إثبات الحكم مبتدأ على وجه يكون دليلا على انتهاء الوقت في حكم كان قبله.
والثاني نسخ بطريق التحويل للحكم من شئ إلى شئ، بمنزلة تحويل فرض التوجه عند أداء الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة، وانتساخ الوصية للوالدين والاقربين بآية الميراث من النوع الثاني، فإن الله تعالى فوض بيان نصيب كل فريق إلى من حضره الموت على أن يراعى الحدود في ذلك، ويبين حصة كل واحد منهم بحسب قرابته، ثم تولى بيان ذلك بنفسه في آية المواريث، وإليه أشار في قوله تعالى: (يوصيكم الله) وإنما تولى بيانه بنفسه لان الموصي ربما كان يقصد إلى المضارة في ذلك، وإلى ذلك أشار في قوله تعالى: (غير مضار وصية من الله) وربما كان لا يحسن التدبير في مقدار ما يوصى لكل واحد منهم
بجهله فبين الله تعالى نصيب كل واحد منهم على وجه يتيقن بأنه هو الصواب وأن فيه الحكمة البالغة، وإلى ذلك أشار في قوله تعالى: (لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) وما هذا إلا نظير من أمر غيره بإعتاق عبده ثم يعتقه بنفسه فينتهي به حكم الوكالة لما باشره الموكل بنفسه، فهنا حين بين الله تعالى نصيب كل قريب لم يبق حكم الوصية إلى الوالدين والاقربين لحصول المقصود بأقوى الطرق، وإليه أشار النبي عليه السلام بقوله: إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث وكان النسخ بهذا الطريق بمنزلة الحوالة، فإن الدين إذا تحول من ذمة إلى ذمة حتى اشتغلت الذمة الثانية به فرغ منه الذمة الاولى وإن لم يكن بين وجوب الدين في الذمتين معنى المنافاة كما يكون بطريق الكفالة.
ولكنا نقول بهذا الطريق يجوز أن يثبت انتهاء حكم وجوب الوصية للوالدين والاقربين، فأما انتهاء حكم جواز الوصية لهم لا يثبت بهذا الطريق، ألا ترى أن بالحوالة وإن لم يبق الدين واجبا في الذمة الاولى فقد بقيت الذمة محلا صالحا لوجوب الدين فيها، وليس من ضرورة انتفاء وجوب الوصية لهم
انتفاء الجواز كالوصية للاجانب.
فعرفنا أنه إنما انتسخ انتفاء وجوب الوصية لهم لضرورة نفي أصل الوصية لهم وذلك ثابت بالسنة، وهو قوله عليه السلام لا وصية لوارث فمن هذا الوجه يتقرر الاستدلال بهذه الآية.
ومنهم من استدل بحكم الحبس في البيوت والاذى باللسان في حق الزاني، فإنه كان بالكتاب ثم انتسخ بالسنة، وهو قوله عليه السلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة وهذا ليس بقوي أيضا، فقد ثبت برواية عمر رضي الله عنه أن الرجم مما كان يتلى في القرآن على ما قال: لولا أن الناس يقولون إن عمر زاد في كتاب الله لكتبت على حاشية
المصحف: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.
الحديث، فإنما كان هذا نسخ الكتاب بالكتاب.
ثم الآية التي فيها بيان حكم الحبس والاذى باللسان فيها بيان توقيت ذلك الحكم بما هو مجمل وهو قوله تعالى: (أو يجعل الله لهن سبيلا) فإنما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المجمل، وإليه أشار في قوله عليه السلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ولا خلاف أن بيان المجمل في كتاب الله تعالى بالسنة يجوز.
ومنهم من استدل بقوله تعالى: (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) فإن هذا حكم منصوص في القرآن، فقد انتسخ وناسخه لا يتلى في القرآن، فعرفنا أنه ثابت بالسنة.
وهذا ضعيف أيضا.
وبين أهل التفسير كلام فيما هو المراد بهذه الآية، وأثبت ما قيل فيه أن من ارتدت زوجته وهربت إلى دار الحرب فقد كان على المسلمين أن يعينوه من الغنيمة بما يندفع به الخسران عنه، وذلك بأن يعطوه مثل ما ساق إليها من الصداق، وإلى ذلك وقعت الاشارة في قوله تعالى: (فعاقبتم) أي عاقبتم المشركين بالسبي والاسترقاق واغتنام أموالهم.
وكان ذلك بطريق الندب على سبيل المساواة ولم ينتسخ هذا الحكم.
فبهذا تبين أنه لا يؤخذ نسخ حكم ثابت بالكتاب بحكم هو ثابت بالسنة ابتداء، وإنما يؤخذ من ذلك الزيادة بالسنة على الحكم الثابت بالكتاب، نحو ما ذهب إليه الشافعي في ضم التغريب إلى الجلد
في حد البكر، فإنه أثبته بقوله: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) ومثل هذه الزيادة عندنا نسخ وعنده بيان بطريق التخصيص ولا يكون نسخا.
فعلى هذا، الكلام يبتنى على ذلك الاصل.
وسنقرر هذا بعد هذا.
ثم الحجة لاثبات جواز نسخ الكتاب بالسنة قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) فإن المراد بيان حكم غير متلو في الكتاب
مكان حكم آخر، وهو متلو على وجه يتبين به مدة بقاء الحكم الاول وثبوت حكم الثاني، والنسخ ليس إلا هذا.
والدليل على أن المراد هذا لا ما توهمه الخصم في بيان الحكم المنزل في الكتاب أنه قال تعالى: (ما نزل إليهم) ولو كان المراد الكتاب لقال ما نزل إليك كما قال تعالى: (بلغ ما أنزل إليك من ربك) والمنزل إلى الناس الحكم الذي أمروا باعتقاده والعمل به، وذلك يكون تارة بوحي متلو، وتارة بوحي غير متلو، وهو ما يكون مسموعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقال إنه سنته، فقد ثبت بالنص أنه كان لا يقول ذلك إلا بالوحي قال تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) ومعنى قوله: (لعلهم يتفكرون) : أي يتفكرون في حجج الشرع ليقفوا بتفكرهم على الحكمة البالغة في كل حجة، أو ليعرفوا الناسخ من المنسوخ.
ووجه الحكمة في تبديل المنسوخ بالناسخ ما يترتب عليه من المنافع للمخاطبين في الدنيا والآخرة، أو يتبين لهم إرادة اليسر والتوسعة للامر عليهم، أو ما يكون لهم فيه من عظيم الثواب، وفي هذا كله لا فرق بين ما يكون ثبوته بوحي متلو وبين ما يكون ثبوته بوحي غير متلو، وفيما تلا من الآية إشارة إلى ما قلنا فإنه قال تعالى: (قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي) فعرفنا أن المراد بيان أنه لا يبدل شيئا من تلقاء نفسه بناء على متابعة الهوى وإنما يوحى إليه فيتبع ما يوحى إليه ويبينه للناس فيما ليس بمنزل في القرآن، ولكن العبارة فيه مفوض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبينه بعبارته، وهو حكم ثابت من الله تعالى بدليل مقطوع به بمنزلة الحكم المتلو في القرآن، ودليل كونه مقطوعا به ما قال إن تصديقنا
إياه فرض علينا من الله تعالى، وكذلك أتباعه لازم بقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وقال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله) فبهذا التقرير يتبين أن بالوحي الذي هو غير متلو (يجوز أن يتبين مدة بقاء الحكم المتلو كما يجوز أن يتبين ذلك بالوحي الذي هو متلو) والنسخ ليس إلا هذا، ألا ترى أنا لو سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحكم هو ثابت بوحي متلو: قد كان هذا الحكم ثابتا إلى الآن وقد انتهى وقته فلا تعملوا به بعده، يلزمنا تصديقه في ذلك والكف عن العمل به، وتكفير من يكذبه في ذلك.
فكذلك إذا ثبت ذلك عندنا بالنقل المتواتر عنه.
فإن قيل: مع هذا في الآية إشارة إلى (أن رسول الله مبين للحكم وفي النسخ بيان حكم ورفع حكم مشروع وليس في الآية إشارة إلى) أنه رافع لحكم ثابت بوحي متلو.
قلنا: نحن نقول هو مبين ولكن في حق الحكم الاول مبين تأويلا وتبليغا وفي حق الحكم الثاني تبليغا وتأويلا.
وبيان هذا أنا قد ذكرنا أن الدليل الموجب لثبوت الحكم وهو الوحي المتلو لا يكون موجبا بقاء الحكم وبالنسخ إنما يرتفع بقاء الحكم الاول، ولم يكن ذلك ثابتا بوحي متلو حتى يكون في بيانه رفع الحكم المتلو مع أنه ليس في النسخ رفع الحكم ولكنه بيان مدة بقاء الحكم، ثم الوقت لا يبقى بعد مضي وقته كما لو كان التوقيت فيه مذكورا في النص المثبت، فعلى هذا التقرير يكون هو مبينا للوقت فيما هو منزل.
فإن قيل: فعلى هذا اختلاط البيان بالنسخ وبالاتفاق بين البيان والنسخ فرق.
قلنا: لا كذلك، فإن كلا واحد منهما في الحقيقة بيان إلا أن البيان المحض يجوز أن يكون مقترنا بأصل الكلام، كدليل الخصوص في العموم، فإنه لا يكون إلا مقارنا، وبيان المجمل فإنه يجوز أن يكون مقارنا.
فأما النسخ (بيان) لا يكون
إلا متأخرا.
وبهذه العلامة يظهر الفرق بينهما، فأما أن يكون النسخ غير
البيان فلا.
فإن قيل: الحكم الثابت بالسنة يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال إنه سنته، وما يكون طريقه الوحي فهو مضاف إلى الله تعالى كالثابت بالوحي المتلو، ففي إضافته إلى رسول الله دليل على أنه ليس ببيان لما هو المنزل بطريق الوحي.
وإذا تقرر هذا فنقول: في النسخ بيان انتهاء مدة كون الحكم حسنا عند الله تعالى وذلك مما لا يمكن معرفته إلا بوحي من الله، فكيف يجوز إثبات نسخ الكتاب بالسنة ؟ قلنا: قد بينا أن ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يبينه عن وحي، والاضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان العبارة في ذلك له، فمن هذا الوجه يقال إنه سنته.
فأما حقيقة الحكم من الله تعالى وقف عليه رسول الله بطريق الوحي ثم بينه للناس.
وبهذا يتبين أنه ما عرف انتهاء مدة الحسن في ذلك الحكم إلا بوحي من الله تعالى، وما هو إلا نظير بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة الحياة لحي قد أحياه الله تعالى، فإن أحدا لا يظن أنه بين ذلك من غير طريق الوحي، وما كانت الاضافة إليه إلا نظير قوله تعالى: (أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟) فإن إضافة الامناء إلى العباد لا يمنع القول بأن الشخص مخلوق خلقه الله تعالى، فكذلك إضافة السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق أنه ظهر لنا بعبارته لا يكون دليلا على أن الحكم غير ثابت بطريق الوحي من الله تعالى، وكما أن الكتاب والسنة كل واحد منهما حجة موجبة للعلم فآيات الكتاب كلها حجة موجبة للعلم.
ثم القول بجواز نسخ الكتاب بالكتاب لا يؤدي إلى القول بالتناقض في الحجة فكذلك في السنن، فإن جواز نسخ السنة بالسنة لا يؤدي إلى التناقض وتطرق الطاعنين إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكذلك جواز نسخ الكتاب بالسنة لا يؤدي إلى ذلك بل يؤدي ذلك إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلى قرب منزلته من حيث
إن الله تعالى فوض بيان الحكم الذي هو وحي في الاصل إليه ليبينه بعبارته، وجعل لعبارته من الدرجة ما يثبت به مدة الحكم الذي هو ثابت بوحي متلو حتى
يتبين به انتساخه.
والدليل عليه أنه لا خلاف بيننا وبين الخصم على جواز نسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ تلاوة الكتاب إنما يكون بغير الكتاب، إما بأن يرفع حفظه من القلوب، أو لا يبقى أحد ممن كان يحفظه نحو صحف إبراهيم ومن تقدمه من الانبياء عليهم السلام، وهذا نسخ الكتاب بغير الكتاب، وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته سورة المؤمنين فأسقط منها آية ثم قال بعد الفراغ ألم يكن فيكم أبي فقال: نعم يا رسول الله.
فقال: هلا ذكرتنيها فقال: ظننت أنها نسخت.
فقال: لو نسخت لانبأتكم بها فقد اعتقد نسخ الكتاب بغير الكتاب ولم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا ثبت جواز نسخ التلاوة بغير الكتاب فكذلك جواز نسخ الحكم، لان وجوب التلاوة والعمل بحكمه كل واحد منهما حكم ثابت بالكتاب.
والدليل على جواز نسخ الحكم الثابت بالكتاب بغيره أن قوله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد) قد انتسخ باتفاق الصحابة، على ما روي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى أبيح له النساء.
وناسخ هذا لا يتلى في الكتاب، فعرفنا أنهم اعتقدوا جواز نسخ الكتاب بغير الكتاب.
فأما قوله تعالى: (نأت بخير منها أو مثلها) فهو يخرج على ما ذكرنا من التقرير، فإن كل واحد من الحكمين ثابت بطريق الوحي، وشارعه علام الغيوب وإن كانت العبارة في أحدهما من حيث الظاهر لرسول الله، فيستقيم إطلاق القول بأن الحكم الثاني مثل الاول أو خير منه على معنى زيادة الثواب والدرجة فيه،
أو كونه أيسر على العباد، أو أجمع لمصالحهم عاجلا وآجلا، إلا أن الوحي المتلو نظمه معجز والذي هو غير متلو نظمه ليس بمعجز، لانه عبارة مخلوق، وهو عليه السلام وإن كان أفصح العرب فكلامه ليس بمعجز، ألا ترى أنه ما تحدى الناس إلى الاتيان بمثل كلامه كما تحداهم إلى الاتيان بمثل سورة من القرآن.
ولكن حكم النسخ لا يختص بالمعجز، ألا ترى أن النسخ يثبت بما دون الآية وبآية واحدة، واتفاق العلماء على صفة الاعجاز في سورة وإن تكلموا فيما دون
السورة.
فعرفنا أن حكم النسخ لا يختص بالمعجز.
وما روي من قوله عليه السلام: فاعرضوه على كتاب الله تعالى فقد قيل هذا الحديث لا يكاد يصح، لان هذا الحديث بعينه مخالف لكتاب الله تعالى، فإن في الكتاب فرضية اتباعه مطلقا، وفي هذا الحديث فرضية اتباعه مقيدا بأن لا يكون مخالفا لما يتلى في الكتاب ظاهرا.
ثم ولئن ثبت فالمراد أخبار الآحاد لا المسموع منه بعينه أو الثابت عنه بالنقل المتواتر، وفي اللفظ ما دل عليه وهو قوله عليه السلام: إذا روي لكم عني حديث ولم يقل إذا سمعتم مني، وبه نقول إن بخبر الواحد لا يثبت نسخ الكتاب، لانه لا يثبت كونه مسموعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا ولهذا لا يثبت به علم اليقين، على أن المراد بقوله: وما خالف فردوه عند التعارض إذا جعل التاريخ بينهما حتى لا يوقف على الناسخ والمنسوخ منهما فإنه يعمل بما في كتاب الله تعالى، ولا يجوز ترك ما هو ثابت في كتاب الله نصا عند التعارض، ونحن هكذا نقول، وإنما الكلام فيما إذا عرف التاريخ بينهما.
والدليل على جواز نسخ السنة بالكتاب قوله تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ) فإن السنة شئ ومطلقها يحتمل التوقيت والتأبيد فناسخها يكون مبينا
معنى التوقيت فيها، والله تعالى بين أن القرآن تبيان لكل شئ فبه يظهر جواز نسخ السنة بالكتاب.
والدليل عليه جواز نسخ السنة بالسنة، فإن كل واحد منهما ثابت بوحي غير متلو فإذا جاز نسخ السنة بوحي غير متلو فلان يجوز نسخها بوحي متلو كان أولى.
والدليل على وجود ذلك أن النبي عليه السلام بعدما قدم المدنية كان يصلي إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا، وهذا الحكم ليس يتلى في القرآن وإنما يثبت بالسنة ثم انتسخ بقوله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام) .
فإن قيل: لا كذلك بل ثبوت هذا الحكم بالكتاب، فإنه كان في شريعة من قبلنا، وعندي شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يقوم الدليل على انتساخه، وهذا حكم ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) قلنا: عندك شريعة من قبلنا تلزمنا بطريق أنه تصير شريعة لنا بسنة رسول الله قولا أو عملا
فلا يخرج بهذا من أن يكون نسخ السنة بالكتاب، مع أن الناسخ ما كان في شريعة من قبلنا قد ثبت بفعل رسول الله حين كان بمكة فإنه كان يصلي إلى الكعبة، ثم بعدما قدم المدينة لما صلى إلى بيت المقدس انتسخت السنة بالسنة، ثم لما نزلت فرضية التوجه إلى الكعبة انتسخت السنة بالكتاب، ولا خلاف أن ما كان في شريعة من قبلنا ثبت انتساخه في حقنا بقول أو فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه وهذا نسخ الكتاب بالسنة.
والدليل عليه أن النبي عليه السلام صالح قريشا عام الحديبية على أن يرد عليهم من جاءه منهم مسلما ثم انتسخ بقوله: (فلا ترجعوهن إلى الكفار) الآية، وهذا نسخ السنة بالكتاب.
وكذلك حكم إباحة الخمر في الابتداء فإنه كان ثابتا بالسنة ثم انتسخ بالكتاب، وهو قوله تعالى: (فاجتنبوه) وحكم حرمة الاكل والشرب والجماع بعد النوم في زمان الصوم كان ثابتا بالسنة ثم انتسخ بقوله تعالى: (فالآن باشروهن) الآية.
ولهذا أمثلة كثيرة.
وأما نسخ الكتاب بالكتاب فنحو وجوب الصفح والاعراض عن المشركين، فإنه كان ثابتا بالكتاب وهو قوله تعالى: (فاصفح الصفح الجميل) ثم انتسخ ذلك بالكتاب بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين) وحرمة فرار الواحد مما دون العشرة من المشركين حكما ثابتا بالكتاب وهو قوله: (وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا) ثم انتسخ بالكتاب وهو قوله: (الآن خفف الله عنكم) .
وأما نسخ السنة بالسنة فبيانه فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه.
وكنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام فأمسكوا وادخروا ما بدا لكم.
وكنت نهيتكم عن الشرب في الدباء والحنتم والمزفت فاشربوا في الظروف فإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، ولا تشربوا مسكرا ثم إنما يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة على وجه لو جهل التاريخ بينهما يثبت حكم التعارض.
فأما بخبر الواحد لا يجوز النسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لان التعارض به لا يثبت بينه وبين الكتاب، فإنه لا يعلم بأنه كلام رسول الله عليه السلام لتمكن الشبهة في طريق النقل، ولهذا لا يوجب العلم، فلا يتبين به أيضا مدة بقاء الحكم الثابت بما يوجب علم اليقين.
فأما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقد كان يجوز أن يثبت نسخ الكتاب بخبر الواحد، ألا ترى أن أهل قباء تحولوا في خلال الصلاة من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة بخبر الواحد ولم ينكر عليهم ذلك رسول الله.
وهذا لان في حياته كان احتمال النسخ والتوقيت قائما في كل حكم لان الوحي كان ينزل حالا فحالا، فأما بعده فلا احتمال للنسخ ابتداء.
ولا بد من أن يكون ما يثبت به النسخ مستندا إلى حال حياته بطريق لا شبهة فيه، وهو النقل المتواتر أو ما يكون في حيز التواتر على الوجه الذي قررنا
فيما سبق، والله أعلم.
فصل: في بيان وجوه النسخ وهذه وجوه أربعة: نسخ التلاوة والحكم جميعا، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم، والنسخ بطريق الزيادة على النص.
فأما الوجه الاول: فنحو صحف إبراهيم ومن تقدمه من الرسل عليهم السلام، فقد علمنا بما يوجب العلم حقيقة أنها قد كانت نازلة تقرأ ويعمل بها، قال تعالى: (إن هذا لفي الصحف الاولى صحف إبراهيم وموسى) وقال تعالى: (وإنه لفي زبر الاولين) ثم لم يبق شئ من ذلك في أيدينا تلاوة ولا عملا به فلا طريق لذلك سوى القول بانتساخ التلاوة والحكم فيما يحتمل ذلك.
وله طريقان: إما صرف الله تعالى عنها القلوب، وإما موت من يحفظها من العلماء لا إلى خلف.
ثم هذا النوع من النسخ في القرآن كان جائزا في حياة رسول الله عليه السلام بقوله تعالى: (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله) فالاستثناء دليل على جواز ذلك.
وقال تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها) وقال: (ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك) فأما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز هذا النوع من النسخ في القرآن عند المسلمين.
وقال بعض الملحدين ممن يتستر بإظهار الاسلام وهو قاصد إلى إفساده هذا جائز بعد وفاته أيضا، واستدل في ذلك بما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم..وأنس رضي الله عنه كان يقول:
قرأنا في القرآن: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا.
وقال عمر رضي الله عنه: قرأنا آية الرجم في كتاب الله ووعيناها.
وقال أبي بن كعب: إن سورة الاحزاب كانت مثل سورة البقرة أو أطول منها.
والشافعي لا يظن به موافقة هؤلاء في هذا القول، ولكنه استدل بما هو قريب من هذا في عدد
الرضعات، فإنه صحح ما يروى عن عائشة رضي الله عنها: وإن مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات، وكان ذلك مما يتلى في القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث.
والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ومعلوم أنه ليس المراد الحفظ لديه، فإن الله تعالى يتعالى من أن يوصف بالنسيان والغفلة، فعرفنا أن المراد الحفظ لدينا، فالغفلة والنسيان متوهم منا وبه ينعدم الحفظ إلا أن يحفظه الله عزوجل، ولانه لا يخلو شئ من أوقات بقاء الخلق في الدنيا عن أن يكون فيما بينهم ما هو ثابت بطريق الوحي فيما ابتلوا به من أداء الامانة التي حملوها، إذ العقل لا يوجب ذلك وليس به كفاية بوجه من الوجوه، وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله عليه السلام، ولو جوزنا هذا في بعض ما أوحي إليه لوجب القول بتجويز ذلك في جميعه فيؤدي إلى القول بأن لا يبقى شئ مما ثبت بالوحي بين الناس في (حال) بقاء التكليف، وأي قول أقبح من هذا ! ومن فتح هذا الباب لم يأمن أن يكون بعض ما في أيدينا اليوم أو كله مخالف لشريعة رسول الله، بأن نسخ الله ذلك بعده وألف بين قلوب الناس على أن ألهمهم ما هو خلاف شريعته، فلصيانة الدين إلى آخر الدهر أخبر الله تعالى أنه هو الحافظ لما أنزله على رسوله، وبه يتبين أنه لا يجوز نسخ شئ منه بعد وفاته بطريق الاندراس وذهاب حفظه من قلوب العباد، وما ينقل من أخبار الآحاد شاذ لا يكاد يصح شئ منها، ويحمل قول من قال في آية الرجم إنه في كتاب الله: أي في حكم الله تعالى، كما قال تعالى (كتاب الله عليكم) : (أي حكم الله عليكم) وحديث عائشة لا يكاد يصح
لانه قال في ذلك الحديث وكانت الصحيفة تحت السرير فاشتغلنا بدفن رسول الله
فدخل داجن البيت فأكله، ومعلوم أن بهذا لا ينعدم حفظه من القلوب، ولا يتعذر عليهم إثباته في صحيفة أخرى، فعرفنا أنه لا أصل هذا الحديث.
فأما الوجهان الآخران فهما جائزان في قول الجمهور من العلماء، ومن الناس من يأبى ذلك.
قالوا لان المقصود بيان الحكم، وإنزال المتلو كان لاجله، فلا يجوز رفع الحكم مع بقاء التلاوة لخلوه عما هو المقصود، ولا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، لان الحكم لا يثبت بدون السبب ولا يبقى بدون بقاء السبب أيضا.
ومنهم من يقول يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ولا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، فإنه لا شك في وجوب الاعتقاد في المتلو أنه قرآن وأنه كلام الله تعالى، كيف يصح أن يعتقد فيه خلاف هذا في شئ من الاوقات والقول بنسخ التلاوة يؤدي إلى هذا، فكان هذا نوعا من الاخبار التي لا يجوز فيها النسخ.
فأما دليلنا على وجود نسخ الحكم مع بقاء التلاوة قوله تعالى: (فأمسكوهن في البيوت) فإن الحبس في البيوت والاذى باللسان كان حد الزنا وقد انتسخ هذا الحكم مع بقاء التلاوة.
وكذلك قوله تعالى: (متاعا إلى الحول غير إخراج) فإن تقدير عدة الوفاة بحول كان منزلا وانتسخ هذا الحكم مع بقاء التلاوة.
وقوله تعالى: (فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) فإن حكم هذا قد انتسخ بقوله: (فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم) وبقيت التلاوة.
وحكم التخيير بين الصوم والفدية قد انتسخ بقوله (فليصمه) وبقيت التلاوة وهو قوله: (وأن تصوموا خير لكم) والدليل على جواز ذلك أنه يتعلق بصيغة التلاوة حكمان مقصودان: أحدهما جواز الصلاة، والثاني النظم المعجز، وبعد انتساخ الحكم الذي هو العمل به يبقى هذان الحكمان وهما مقصودان، ألا ترى أن بالمتشابه في القرآن إنما يثبت هذان الحكمان فقط، وإذا حسن ابتداء رسم التلاوة لهذين الحكمين فالبقاء أولى.
وقد بينا أن
الدليل الموجب لثبوت الحكم لا يكون موجبا للبقاء، وبالانتساخ إنما ينعدم بقاء الحكم، وذلك ما كان مضافا إلى ما كان موجبا ثبوت الحكم، فانتهاء الحكم لا يمنع بقاء التلاوة من هذا الوجه.
وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فبيانه فيما قال علماؤنا: إن صوم كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعة، بقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
وقد كانت هذه قراءة مشهورة إلى زمن أبي حنيفة.
ولكن لم يوجد فيه النقل المتواتر الذي يثبت بمثله القرآن، وابن مسعود لا يشك في عدالته وإتقانه، فلا وجه لذلك إلا أن نقول كان ذلك مما يتلى في القرآن كما حفظه ابن مسعود رضي الله عنه ثم انتسخت تلاوته في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بصرف الله القلوب عن حفظها إلا قلب ابن مسعود ليكون الحكم باقيا بنقله، فإن خبر الواحد موجب للعمل به وقراءته لا تكون دون روايته، فكان بقاء هذا الحكم بعد نسخ التلاوة بهذا الطريق.
والدليل على جوازه ما بينا أن بقاء الحكم لا يكون ببقاء السبب الموجب له، فانتساخ التلاوة لا يمنع بقاء الحكم، ألا ترى أن البيع موجب للملك ثم لو قطع المشتري ملكه بالبيع من غيره أو أزاله بالاعتاق لم ينعدم ذلك البيع، لان البقاء لم يكن مضافا إليه.
ثم قد بينا أن حكم تعلق جواز الصلاة بتلاوته وحرمة قراءته على الجنب والحائض مقصود، وهو مما يجوز أن يكون موقتا ينتهي بمضي مدته فيكون نسخ التلاوة بيان مدة ذلك الحكم، كما أن نسخ الحكم بيان المدة فيه، وما توهمه بعضهم فهو غلط بين، فإن بعدما اعتقدنا في المتلو أنه قرآن وأنه كلام الله تعالى لا نعتقد فيه أنه ليس بقرآن وأنه ليس بكلام الله تعالى بحال من الاحوال، ولكن بانتساخ التلاوة ينتهي حكم تعلق جواز الصلاة به، وحرمة قراءته على الجنب والحائض لضرورة أن الله تعالى رفع عنا تلاوته وحفظه وهو نظير ما يقول، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
ما قبض نعتقد فيه أنه رسول الله وأنه خاتم الانبياء عليهم السلام على ما كان في حال حياته وإن أخرجه الله من بيننا بانتهاء مدة حياته في الدنيا.
وأيد جميع ما ذكرنا قوله تعالى: (ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك) ثم قد بينا أنه يجوز إثبات الحكم ابتداء بوحي غير متلو فلان يجوز بقاء الحكم بعدما انتسخ حكم التلاوة من الوحي المتلو كان أولى.
وأما الوجه الرابع وهو الزيادة على النص فإنه بيان صورة ونسخ معنى عندنا سواء كانت الزيادة في السبب أو الحكم، وعلى قول الشافعي هو بمنزلة تخصيص العام ولا يكون فيه معنى النسخ حتى جوز ذلك بخبر الواحد والقياس.
وبيان هذا في النفي مع الجلد، وقيد صفة الايمان في الرقبة في كفارة الظهار واليمين.
وجه قوله إن الرقبة اسم عام يتناول المؤمنة والكافرة، فإخراج الكافرة منها يكون تخصيصا لا نسخا بمنزلة إخراج بعض الاعيان من الاسم العام، ألا ترى أن بني إسرائيل استوصفوا البقرة وكان ذلك منهم طلب البيان المحض دون النسخ، وبعدما بينها الله لهم امتثلوا الامر المذكور في قوله: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) وهذا لان النسخ يكون برفع الحكم المشروع وفي الزيادة تقرير الحكم المشروع وإلحاق شئ آخر به بطريق المحاورة، فإن إلحاق النفي بالجلد لا يخرج الجلد من أن يكون مشروعا، وإلحاق صفة الايمان بالرقبة لا يخرج الرقبة من أن تكون مستحقة الاعتاق في الكفارة.
وهذا نظير حقوق العباد، فإن من ادعى على غيره ألفا وخمسائة وشهد له شاهدان بألف وآخران بألف وخمسائة حتى قضى له بالمال كله كان مقدار الالف مقضيا به بشهادتهم جميعا، وإلحاق الزيادة بالالف في شهادة الآخر يوجب تقرير الاصل في كونه مشهودا به لا رفعه.
فتبين بهذا أن الزيادة لا تتعرض لاصل الحكم المشروع فلا يكون فيها معنى النسخ بوجه من الوجوه.
ثم قد يكون بطريق التخصيص وقد لا يكون،
ولهذا لا يشترط فيها أن تكون مقرونة بالاصل كما يشترط ذلك في دليل الخصوص، وحاجتنا إلى إثبات أن ذلك ليس بنسخ وقد أثبتناه بما قررنا.
وحجتنا في ذلك أن أكثر ما ذكره الخصم دليل على أن الزيادة بيان صورة، ونحن نسلم ذلك ولكنا ندعي أنه نسخ معنى، والدليل على إثبات ذلك أن ما يجب حقا لله تعالى من عبادة أو عقوبة أو كفارة لا يحتمل الوصف بالتجزي وليس للبعض منه حكم الجملة بوجه، فإن الركعة من صلاة الفجر لا تكون فجرا والركعتين من صلاة الظهر في حق المقيم لا تكون ظهرا، وكذلك المظاهر إذا صام شهرا ثم عجز فأطعم ثلاثين مسكينا لا يكون مكفرا به بالاطعام
ولا بالصوم، ولهذا قلنا: القاذف إذا جلد تسعة وسبعين سوطا لا تسقط شهادته، لان الحد ثمانون سوطا فبعضه لا يكون حدا.
إذا تقرر هذا فنقول: الثابت بآية الزنا جلد وهو حد، فإذا التحق النفي به يخرج الجلد من أن يكون حدا لانه يكون بعض الحد حينئذ وبعض الحد ليس بحد، بمنزلة بعض العلة فإنه لا يوجب شيئا من الحكم الثابت بالعلة فكان نسخا من هذا الوجه، وكذلك في الرقبة فإن مع الاطلاق التكفير بتحرير رقبة، وبعد القيد تحرير رقبة بعض ما يتأدى به الكفارة.
فعرفنا أنه نسخ وبه فارق حقوق العباد، فإنه مما يحتمل الوصف بالتجزي فيمكن أن يجعل إلحاق الزيادة به تقريرا للمزيد عليه، حتى إن فيما لا يحتمل التجزي من حقوق العباد الحكم كذلك أيضا، فإن البيع لما كان عبارة عن الايجاب والقبول لم يكن الايجاب المحض بيعا، ونكاح أربع نسوة لما كان موجبا حرمة النكاح عليه لا يثبت شئ من ذلك بنكاح امرأة أو امرأتين لان ليس بنكاح أربع نسوة، وقد بينا في قصة بني إسرائيل أن ذلك كان بيانا صورة وكان نسخا معنى، كما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: شددوا فشدد الله عليهم.
يدل عليه أن النسخ لبيان مدة بقاء
الحكم وإثبات حكم آخر، ثم الاطلاق ضد التقييد فكان من ضرورة ثبوت التقييد انعدام صفة الاطلاق، وذلك لا يكون إلا بعد انتهاء مدة حكم الاطلاق وإثبات حكم هو ضده وهو التقييد، وإذا كان إثبات حكم غير الاول على وجه يعلم أنه لم يبق معه الاول نسخا فإثبات حكم هو ضد الاول أولى أن يكون نسخا بطريق المعنى، وبه فارق التخصيص فإن التخصيص لا يوجب حكما فيما تناوله العام غير الحكم الاول، ولكن يبين أن العام لم يكن متناولا لما صار مخصوصا منه، ولهذا لا يكون التخصيص إلا مقارنا، يقرره أن التخصيص للاخراج والتقييد للاثبات، وأي مشابهة تكون بين الاخراج من الحكم وبين إثبات الحكم.
وهذا لان الاطلاق يعدم صفة التقييد والتقييد إيجاد لذلك الوصف، فبعد ما ثبت التقييد لا يتصور بقاء صفة الاطلاق، ولا يكون الحكم ثابتا لما تناوله صيغة الاطلاق، وإنما يكون ثابتا بالمقيد من اللفظ، فأما العام إذا خص منه شئ يبقى الحكم ثابتا فيما وراءه بمقتضى لفظ العموم فقط،
وإذا كان بقاء الحكم بما كان النص العام متناولا له عرفنا أن التخصيص لا يكون تعرضا لما وراء المخصوص بشئ.
وبيان هذا أن قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين) وإن خص منه أهل الذمة وغيرهم فمن لا أمان له يجب قتله لانه مشرك.
وفي قوله: (فتحرير رقبة) إذا قيدنا بصفة الايمان لا تتأدى الكفارة بما يتناوله اسم الرقبة بل بما يتناوله اسم الرقبة المؤمنة.
فعرفنا أنه في معنى النسخ وليس بتخصيص، ولان التخصيص يصرف فيما كان اللفظ متناولا له باعتبار دليل الظاهر لولا دليل الخصوص، والتقييد تصرف فيما لم يكن اللفظ متناولا له أصلا لولا التقييد، فإن اسم الرقبة لا يتناول صفتها من حيث الايمان والكفر، فعرفنا أنه نسخ والنسخ في الحكم الثابت بالنص لا يكون بخبر الواحد ولا بالقياس.
وعلى هذا قلنا: لا تتعين الفاتحة للقراءة في الصلاة ركنا لانه زيادة على ما ثبت بالنص، ولا تثبت الطهارة عن الحدث شرطا في
ركن الطواف لانه زيادة على النص، ولا يثبت النفي حدا مع الجلد في زنا البكر لانه زيادة، ولا يثبت اشتراط صفة الايمان في كفارة اليمين والظهار لانه زيادة.
وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: شرب القليل من الطلاء المثلث لا يكون حراما لان المحرم السكر بالنص، وشرب القليل بعض العلة فيما يحصل به السكر فلا يكون مسكرا.
وعلى هذا قال أصحابنا: إذا وجد المحدث من الماء ما لا يكفيه لوضوئه أو الجنب ما لا يكفيه لاغتساله فإنه يتيمم ولا يستعمل ذلك الماء، لان الواجب استعمال الماء الذي هو طهور، وهذا بمنزلة بعض العلة في حكم الطهارة فلا يكون طهورا فوجوده لا يمنع التيمم.
وعلى هذا قلنا: إذا شهد أحد الشاهدين بالبيع بألف والآخر بالبيع بألف وخمسمائة لا تقبل الشهادة في إثبات العقد بألف، وإن اتفق عليه الشاهدان ظاهرا لان الذي شهد بألف وخمسمائة قد جعل الالف بعض الثمن وانعقاد البيع بجميع الثمن المسمى لا ببعضه، فمن هذا الوجه كل واحد منهما في المعنى شاهد لعقد آخر والالف المذكور في شهادة الثاني كان بحيث يثبت به العقد لولا وصل شئ آخر به بمنزلة التخيير في الطلاق والعتاق يصير شيئا آخر إذا اتصل به التعليق بالشرط فحكم الزيادة يكون بهذه الصفة أيضا.
والذي يقرر جميع ما ذكرنا أن النسخ إنما يثبت بما لو جهل التاريخ فيه كان معارضا وهذا يتحقق في الاطلاق والتقييد، فإنه لو جهل التاريخ بين النص المطلق والمقيد يثبت التعارض بينهما، فعرفنا أنه عند معرفة التاريخ بينهما يكون
التقييد في النص المطلق نسخا من حيث المعنى، ويجوز أن يرد النسخ على ما هو ناسخ كما يجوز أن يرد النسخ على ما كان مشروعا ابتداء إذ المعنى لا يوجب الفرق بينهما.
وبيان هذا فيما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حرمة مفاداة الاسير الثابت بقوله تعالى: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى) قد انتسخ بقوله تعالى: (فإما منا بعد وإما فداء) ثم قال السدي: هذا قد انتسخ بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين
حيث وجدتموهم) لان سورة براءة من آخر ما نزل فكان ناسخا للحكم الذي كان قبله.
وكذلك حكم الحبس في البيوت والاذى باللسان في كونه حدا قد انتسخ بقوله عليه السلام: (خذوا عني) الحديث.
ثم هذا الحكم انتسخ بنزول قوله تعالى: (فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وبرجم النبي عليه السلام ماعز بن مالك رضي الله عنه، واستقر الحكم على أن الحد الكامل في حق غير المحصن مائة جلدة وفي حق المحصن الرجم.
ومما اختلفوا في أنه نسخ أم لا حكم الميراث، فقد كان التوريث بالحلف والهجرة ثابتا في الابتداء، قال تعالى: (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) وقال تعالى: (إن الذين آمنوا وهاجروا) إلى قوله: (أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا) الآية، ثم انتسخ هذا عند بعض العلماء بنزول قوله تعالى: (وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) الآية.
ومنهم من قال: هذا ليس بنسخ ولكن هذا تقديم وارث على وارث فلا يكون نسخا، كتقديم الابن على الاخ في الميراث لا يكون نسخ التوريث بالاخوة، وتقديم الشريك على الجار في استحقاق الشفعة لا يكون نسخ حكم الشفعة بالجوار.
والاصح أن نقول: هذا نسخ بعض الاحوال دون البعض، فإن قوله تعالى: (فآتوهم نصيبهم) تنصيص على أن بالحلف يستحق النصيب من الميراث مع وجود القريب، ثم انتسخ هذا الحكم بقوله تعالى: (وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) حتى لا يستحق بالحلف شيئا مع وجود القريب أصلا.
فعرفنا أن هذا الحكم قد انتهى في هذه الحالة فكان نسخا وإن كان
الارث بهذا السبب باقيا في غير هذه الحالة، وإلى ذلك أشار ابن مسعود رضي
الله عنه في قوله: يا معشر همدان إنه ليس حي من أحياء العرب أحرى أن يموت الرجل فيهم ولا يعرف له نسب منكم فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أحب.
والله أعلم.
باب: الكلام في أفعال النبي عليه السلام اعلم بأن أفعاله التي تكون عن قصد تنقسم أربعة أقسام: مباح، ومستحب، وواجب، وفرض.
وهنا نوع خامس وهو الزلة، ولكنه غير داخل في هذا الباب، لانه لا يصلح للاقتداء به في ذلك، وعقد الباب لبيان حكم الاقتداء به في أفعاله، ولهذا لم يذكر في الجملة ما يحصل في حالة النوم والاغماء لان القصد لا يتحقق فيه فلا يكون داخلا فيما هو حد الخطاب.
وأما الزلة فإنه لا يوجد فيها القصد إلى عينها أيضا، ولكن يوجد القصد إلى أصل الفعل.
وبيان هذا أن الزلة أخذت من قول القائل: زل الرجل في الطين إذا لم يوجد القصد إلى الوقوع ولا إلى الثبات بعد الوقوع، ولكن وجد القصد إلى المشي في الطريق، فعرفنا بهذا أن الزلة ما تتصل بالفاعل عند فعله ما لم يكن قصده بعينه، ولكنه زل فاشتغل به عما قصد بعينه، والمعصية عند الاطلاق إنما يتناول ما يقصده المباشر بعينه وإن كان قد أطلق الشرع ذلك على الزلة مجازا.
ثم لا بد أن يقترن بالزلة بيان من جهة الفاعل أو من الله تعالى، كما قال تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام عند قتل القبطي: (هذا من عمل الشيطان) الآية، وكما قال تعالى: (وعصى آدم ربه فغوى) الآية وإذا كان البيان يقترن به لا محالة علم أنه غير صالح للاقتداء به.
ثم اختلف الناس في أفعاله التي لا تكون عن سهو ولا من نتيجة الطبع على ما جبل عليه الانسان ما هو موجب ذلك في حق أمته.
فقال بعضهم: الواجب هو الوقف في ذلك حتى يقوم الدليل.
وقال بعضهم: بل يجب اتباعه
والاقتداء به في جميع ذلك إلا ما يقوم عليه دليل.
وكان أبو الحسن الكرخي
رحمه الله يقول: إن علم صفة فعله أنه فعله واجبا أو ندبا أو مباحا فإنه يتبع فيه بتلك الصفة، وإن لم يعلم فإنه يثبت فيه صفة الاباحة، ثم لا يكون الاتباع فيه ثابتا إلا بقيام الدليل.
وكان الجصاص رحمه الله يقول بقول الكرخي رحمه الله إلا أنه يقول: إذا لم يعلم فالاتباع له في ذلك ثابت حتى يقوم الدليل على كونه مخصوصا.
وهذا هو الصحيح.
فأما الواقفون احتجوا فقالوا: لما أشكل صفة فعله فقد تعذر اتباعه في ذلك على وجه الموافقة، لان ذلك لا يكون بالموافقة في أصل الفعل دون الصفة، فإنه إذا كان هو فعل فعلا نفلا ونحن نفعله فرضا يكون ذلك منازعة لا موافقة، واعتبر هذا بفعل السحرة مع ما رأوه من الكليم ظاهرا فإنه كان منازعة منهم في الابتداء، لان فعلهم لم يكن بصفة فعله، فعرفنا أن الوصف إذا كان مشكلا لا تتحقق الموافقة في الفعل لا محالة، ولا وجه للمخالفة فيجب الوقف فيه حتى يقوم الدليل.
وهذا الكلام عند التأمل باطل، فإن هذا القائل إن كان يمنع الامة من أن يفعلوا مثل فعله بهذا الطريق ويلومهم على ذلك فقد أثبت صفة الحظر في الاتباع، وإن كان لا يمنعهم من ذلك ولا يلومهم عليه فقد أثبت صفة الاباحة، فعرفنا أن القول بالوقف لا يتحقق في هذا الفصل.
وأما الفريق الثاني فقد استدلوا بالنصوص الموجبة للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، نحو قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وقوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) ، وقوله تعالى: (فاتبعوني يحببكم الله) وقوله تعالى: (الذين يتبعون الرسول النبي
الامي) إلى قوله: (واتبعوه لعلكم تهتدون) وقوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) : أي عن سمته وطريقته.
وقال تعالى: (وما أمر فرعون برشيد) ففي هذه النصوص دليل على وجوب الاتباع علينا إلى أن يقوم الدليل يمنع من ذلك.
فأما الدليل لنا في هذا الفصل أن نقول: صح في الحديث أن النبي عليه
السلام خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ قال: ما لكم خلعتم نعالكم الحديث.
فلو كان مطلق فعله موجبا للمتابعة لم يكن لقوله: ما لكم خلعتم نعالكم معنى.
وخرج للتراويح ليلة أو ليلتين فلما قيل له في ذلك قال: خشيت أن تكتب عليكم ولو كتبت عليكم ما قمتم بها فو كان مطلق فعله يلزمنا الاتباع له في ذلك لم يكن لقوله: خشيت أن تكتب عليكم معنى.
ثم قد بينا أن الموافقة حقيقتها في أصل الفعل وصفته فعند الاطلاق إنما يثبت القدر المتيقن به وهو صفة الاباحة، فإنه يترتب عليه التمكن من إيجاد الفعل شرعا، فيثبت القدر المتيقن به (وهو صفة الاباحة) من الوصف، ويتوقف ما وراء ذلك على قيام الدليل، بمنزلة رجل يقول لغيره: وكلتك بمالي فإنه يملك الحفظ، لانه متيقن لكونه مراد الموكل، ولا يثبت ما سوى ذلك من التصرفات حتى يقوم الدليل، يقرر ما ذكرنا أن الفعل قسمان: أخذ، وترك.
ثم أحد قسمي أفعاله وهو الترك لا يوجب الاتباع علينا إلا بدليل فكذلك القسم الآخر.
وبيان هذا أنه حين كان الخمر مباحا قد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شربها أصلا، ثم ذلك لا يوجب علينا ترك الشرب فيما هو مباح، يوضحه أن مطلق فعله لو كان موجبا للاتباع لكان ذلك عاما في جميع أفعاله ولا وجه للقول بذلك، لان ذلك يوجب على كل أحد أن
لا يفارقه آناء الليل والنهار ليقف على جميع أفعاله فيقتدي به، لانه لا يخرج عن الواجب إلا بذلك، ومعلوم أن هذا مما لا يتحقق ولا يقول به أحد.
فعرفنا أن مطلق الفعل لا يلزمنا اتباعه في ذلك.
فأما الآيات ففي قوله: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) دليل على أن التأسي به في أفعاله ليس بواجب، لانه لو كان واجبا لكان من حق الكلام أن يقول عليكم، ففي قوله (لكم) دليل على أن ذلك مباح لنا لا أن يكون لازما علينا.
والمراد بالامر بالاتباع التصديق والاقرار بما جاء به، فإن الخطاب بذلك لاهل الكتاب وذلك بين في سياق الآية، والمراد بالامر ما يفهم من مطلق لفظ الامر عند
الاطلاق، وقد تقدم بيان هذا في أول الكتاب.
ثم قال الكرخي: قد ظهر خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء لاختصاصه بما لا شركة لاحد من أمته معه في ذلك، فكل فعل يكون منه فهو محتمل للوصف لجواز أن يكون هذا مما اختص هو به ويجوز أن يكون مما هو غير مخصوص به، وعند احتمال الجانبين على السواء يجب الوقف حتى يقوم الدليل لتحقق المعارضة.
ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجصاص، لان في قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) تنصيص على جواز التأسي به في أفعاله، فيكون هذا النص معمولا به حتى يقوم الدليل المانع وهو ما يوجب تخصيصه بذلك، وقد دل عليه قوله تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم) وفي هذا بيان أن ثبوت الحل في حقه مطلقا دليل ثبوته في حق الامة، ألا ترى أنه نص على تخصيصه فيما كان هو مخصوصا به بقوله تعالى: (خالصة لك من دون المؤمنين) وهو النكاح بغير مهر، فلو لم يكن مطلق فعله دليلا للامة في الاقدام على مثله لم يكن لقوله: (خالصة
لك) فائدة، فإن الخصوصية تكون ثابتة بدون هذه الكلمة، والدليل عليه أنه عليه السلام لما قال لعبد الله بن رواحة حين صلى على الارض في يوم قد مطروا في السفر: ألم يكن لك في أسوة ؟ فقال: أنت تسعى في رقبة قد فكت وأنا أسعى في رقبة لم يعرف فكاكها.
فقال: إني مع هذا أرجو أن أكون أخشاكم لله ولما سألت امرأة أم سلمة عن القبلة للصائم فقالت: إن رسول الله عليه السلام يقبل وهو صائم.
فقالت لسنا كرسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤالها فقال: هلا أخبرتها أني أقبل وأنا صائم ؟ فقالت: قد أخبرتها بذلك فقالت كذا.
فقال: إني أرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده ففي هذا بيان أن اتباعه فيما يثبت من أفعاله أصل حتى يقوم الدليل على كونه مخصوصا بفعله، وهذا لان الرسل أئمة يقتدى بهم، كما قال تعالى: (إني
جاعلك للناس إماما) فالاصل في كل فعل يكون منهم جواز الاقتداء بهم، إلا ما يثبت فيه دليل الخصوصية باعتبار أحوالهم وعلو منازلهم، وإذا كان الاصل هذا ففي كل فعل يكون مبهم بصفة الخصوص يجب بيان الخصوصية مقارنا به، إذ الحاجة إلى ذلك ماسة عند كل فعل يكون (منهم) حكمه بخلاف هذا الاصل والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة دليل النفي، فترك بيان الخصوصية يكون دليلا على أنه من جملة الافعال التي هو فيها قدوة أمته.
فصل: في بيان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إظهار أحكام الشرع قد بينا أنه كان يعتمد الوحي فيما بينه من أحكام الشرع.
والوحي نوعان: ظاهر، وباطن.
فالظاهر منه قسمان: (أحدهما) ما يكون على لسان الملك
بما يقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ بأنه قاطعة، وهو المراد بقوله تعالى: (قل نزله روح القدس من ربك بالحق) وبقوله تعالى: (إنه لقول رسول كريم) الآية، والآخر ما يتضح له بإشارة الملك من غير بيان بكلام، وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب والوحي الباطن هو: تأييد القلب على وجه لا يبقى فيه شبهة ولا معارض ولا مزاحم، وذلك بأن يظهر له الحق بنور في قلبه من ربه يتضح له حكم الحادثة به، وإليه أشار الله تعالى بقوله: (لتحكم بين الناس بما أراك الله) وهذا كله مقرونا بالابتلاء، ومعنى الابتلاء هو: التأمل بقلبه في حقيقته حتى يظهر له ما هو المقصود، وكل ذلك خاص لرسول الله تثبت به الحجة القاطعة، ولا شركة للامة في ذلك إلا أن يكرم الله به من شاء من أمته لحقه وذلك الكرامة للاولياء.
وأما ما يشبه الوحي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو استنباط الاحكام من النصوص بالرأي
والاجتهاد فإنما يكون من رسول الله بهذا الطريق، فهو بمنزلة الثابت بالوحي لقيام الدليل على أنه يكون ثوابا لا محالة، فإنه كان لا يقر على الخطأ فكان ذلك منه حجة قاطعة، ومثل هذا من الامة لا يجعل بمنزلة الوحي، لان المجتهد يخطئ ويصيب، فقد علم أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة الكمال ما لا يحيط به إلا الله، فلا شك أن غيره لا يساويه في إعمال الرأي والاجتهاد في الاحكام.
وهذا يبتنى على اختلاف العلماء في أنه عليه السلام هل كان يجتهد في الاحكام ويعمل بالرأي فيما لا نص فيه ؟ فأبى ذلك بعض العلماء وقال: هذا الطريق حظ الامة، فأما حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العمل بالوحي من الوجوه التي ذكرنا.
وقال بعضهم: قد كان يعمل بطريق الوحي تارة وبالرأي تارة، وبكل واحد من الطريقين
كان يبين الاحكام.
وأصح الاقاويل عندنا أنه عليه السلام فيما كان يبتلى به من الحوادث التي ليس فيها وحي منزل كان ينتظر الوحي إلى أن تمضي مدة الانتظار، ثم كان يعمل بالرأي والاجتهاد ويبين الحكم به فإذا أقر عليه كان ذلك حجة قاطعة للحكم.
فأما الفريق الاول فاحتجوا بقوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) وقال تعالى: (قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي) ولانه لا خلاف أنه كان لا يجوز لاحد مخالفة رسول الله عليه السلام فيما بينه من أحكام الشرع، والرأي قد يقع فيه الغلط في حقه وفي حق غيره، فلو كان يبين الحكم بالرأي لكان يجوز مخالفته في ذلك كما في أمر الحرب، فقد ظهر أنهم خالفوه في ذلك غير مرة واستصوبهم في ذلك، ألا ترى أنه لما أراد النزول يوم بدر دون الماء قال له الخباب بن المنذر رضي الله عنه: إن كان عن وحي فسمعا وطاعة، وإن كان عن رأي فإني أرى الصواب أن ننزل على الماء ونتخذ الحياض، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه ونزل على الماء.
ولما أراد يوم الاحزاب أن يعطي المشركين شطر ثمار المدينة لينصرفوا قام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما وقالا: إن كان هذا عن وحي فسمعا وطاعة، وإن كان عن رأي فلا نعطيهم إلا السيف، قد كنا نحن وهم في الجاهلية لم يكن لنا ولا لهم دين فكانوا لا يطمعون
في ثمار المدينة إلا بشري أو بقري فإذا أعزنا الله تعالى بالدين نعطيهم الدنية لا نعطيهم إلا السيف.
وقال عليه السلام: إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أصرفهم عنكم فإذا أبيتم أنتم وذاك ثم قال للذين جاءوا للصلح: اذهبوا فلا نعطيكم إلا السيف ولما قدم المدينة استقبح ما كانوا يصنعونه من تلقيح النخيل فنهاهم عن ذلك فأحشفت وقال: عهدي بثماركم بخلاف هذا فقالوا:
نهيتنا عن التلقيح وإنما كانت جودة الثمر من ذلك.
قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم وأنا أعلم بأمر دينكم فتبين أن الرأي منه كالرأي من غيره في احتمال الغلط، وبالاتفاق لا تجوز مخالفته فيما ينص عليه من أحكام الشرع، فعرفنا أن طريق وقوفه على ذلك ما ليس فيه توهم الغلط أصلا وذلك الوحي، ثم الرأي الذي فيه توهم الغلط إنما يجوز المصير إليه عند الضرورة وهذه الضرورة تثبت في حق الامة لا في حقه، فقد كان الوحي يأتيه في كل وقت، وما هذا إلا نظير التحري في أمر القبلة فإنه لا يجوز المصير إليه لمن كان بمكة معاينا للكعبة، ويجوز المصير إليه لمن كان نائيا عن الكعبة، لان من كان معاينا فالضرورة المحوجة إلى التحري لا تتحقق في حقه لوجود الطريق الذي لا يتمكن فيه تهمة الغلط وهو المعاينة، وكذلك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل بالرأي في الاحكام، ولانه عليه السلام كان ينصب أحكام الشرع ابتداء والرأي لا يصلح لنصب الحكم به ابتداء وإنما هو لتعدية حكم النص إلى نظيره مما لا نص فيه كما في حق الامة، لانه لا يجوز لاحد استعمال الرأي في نصب حكم ابتداء، فعرفنا أنه إنما كان ينصب الحكم ابتداء بطريق الوحي دون الرأي، وهذا لان الحق في أحكام الشرع لله تعالى فإنما يثبت حق الله تعالى بما يكون موجبا للعلم قطعا والرأي لا يوجب ذلك، وبه فارق أمر الحرب والشورى في المعاملات، لان ذلك من حقوق العباد، فالمطلوب به الدفع عنهم أو الجر إليهم فيما تقوم به مصالحهم، واستعمال الرأي جائز في مثله لحاجة العباد إلى ذلك، فإنه ليس في وسعهم فوق ذلك، والله تعالى يتعالى عما يوصف به العباد من العجز أو الحاجة، فما هو حق الله تعالى لا يثبت ابتداء إلا بما يكون موجبا علم اليقين.
والحجة للقول الثاني قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الابصار) ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولي الناس بهذا الوصف الذي ذكره عند الامر بالاعتبار، فعرفنا
أنه داخل في هذا الخطاب، قال تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) وقد دخل في جملة المستنبطين من تقدم ذكره، فعرفنا أن الرسول من جملة الذين أخبر الله أنهم يعلمون بالاستنباط، وقال تعالى: (ففهمناها سليمان) والمراد أنه وقف على الحكم بطريق الرأي لا بطريق الوحي، لان ما كان بطريق الوحي فداود وسليمان عليهما السلام فيه سواء، وحيث خص سليمان عليه السلام بالفهم عرفنا أن المراد به بطريق الرأي، وقد حكم داود بين الخصمين حين تسوروا المحراب بالرأي، فإنه قال: (لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) وهذا بيان بالقياس الظاهر.
وقال النبي عليه السلام للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيت أكان يقبل منك ؟ وهذا بيان بطريق القياس.
وقال لعمر رضي الله عنه حين سأله عن القبلة للصائم: أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك ؟ وقال في حرمة الصدقة على بني هاشم: أرأيت لو تمضمضت بالماء أكنت شاربه ؟ وهذا بيان بطريق القياس في حرمة الاوساخ واستعمال المستعمل.
وقال: إن الرجل ليؤجر في كل شئ حتى في مباضعة أهله فقيل له: يقضي أحدنا شهوته ثم يؤجر على ذلك ؟ قال: أرأيتم لو وضع ذلك فيما لا يحل هل كان يأثم به ؟ قالوا: نعم.
قال: فكذلك يؤجر إذا وضعه فيما يحل وهذا بيان بطريق الرأي والاجتهاد.
والدليل عليه أنه كان مأمورا بالمشاورة مع أصحابه، قال تعالى: (وشاورهم في الامر) وقد صح أنه كان يشاورهم في أمر الحرب وغير ذلك حتى روي أنه شاور أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في مفاداة الاسارى يوم بدر فأشار عليه أبو بكر بأن يفادي بهم، ومال رأيه إلى ذلك حتى نزل قوله تعالى: (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) ومفاداة الاسير بالمال جوازه وفساده من أحكام الشرع ومما هو حق الله تعالى، وقد شاور فيه أصحابه وعمل فيه بالرأي إلى أن نزل الوحي بخلاف ما رآه، فعرفنا أنه كان يشاورهم في الاحكام
كما في الحروب، وقد شاورهم فيما يكون جامعا لهم في أوقات الصلاة ليؤدوها بالجماعة، ثم لما جاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه وذكر ما رأى في المنام من أمر الاذان
فأخذ به وقال: (ألقها على بلال) ومعلوم أنه أخذ بذلك بطريق الرأي دون طريق الوحي، ألا ترى أنه لما أتى عمر وأخبره أنه رأى مثل ذلك قال الله أكبر هذا أثبت، ولو كان قد نزل عليه الوحي به لم يكن لهذا الكلام معنى، ولا شك أن حكم الاذان مما هو (من) حق الله ثم قد جوز العمل فيه بالرأي، فعرفنا أن ذلك جائز، ولا معنى لقول من يقول إنه إنما كان يستشيرهم في الاحكام لتطييب نفوسهم، وهذا لان فيما كان الوحي فيه ظاهرا معلوما ما كان يستشيرهم، وفيما كان يستشيرهم الحال لا يخلو إما أن كان يعمل برأيهم أو لا يعمل، فإن كان لا يعمل برأيهم وكان ذلك معلوما لهم فليس في هذه الاستشارة تطييب النفس ولكنها من نوع الاستهزاء وظن ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم محال، وإن كان يستشيرهم ليعمل برأيهم فلا شك أن رأيه يكون أقوى من رأيهم، وإذا جاز له العمل برأيهم فيما لا نص فيه فجواز ذلك برأيه أولى.
ويتبين بهذا أنه إنما كان يستشيرهم لتقريب الوجوه وتحميس الرأي، على ما كان يقول: المشورة تلقيح العقول وقال: من الحزم أن تستشير ذا رأي ثم تطيعه ثم الاستنباط بالرأي إنما يبتنى على العلم بمعاني النصوص، ولا شك أن درجته في ذلك أعلى من درجة غيره، وقد كان يعلم بالمتشابه الذي لا يقف أحد من الامة بعده على معناه، فعرفنا بهذا أن له من هذه الدرجة أعلى النهاية، وبعد العلم بالطريق الذي يوقف به على الحكم المنع من استعمال ذلك نوع من الحجر، وتجويز استعمال ذلك نوع إطلاق وإنما يليق بعلو درجته الاطلاق دون الحجر.
وكذلك ما يعلم بطريق الوحي فهو محصور متناه، وما يعلم بالاستنباط من معاني الوحي غير متناه.
وقيل أفضل
درجات العلم للعباد طريق الاستنباط، ألا ترى أن من يكون مستنبطا من الامة فهو على درجة ممن يكون حافظا غير مستنبط، فالقول بما يوجب سد باب ما هو أعلى الدرجات في العلم عليه شبه المحال، ولولا طعن المتعنتين لكان الاولى بنا الكف عن الاشتغال بإظهار هذا بالحجة، فقد كان درجته في العلم ما لا
يحيط به إلا الله، وتمام معنى التعظيم في حق من هو دونه أن لا يشتغل بمثل هذا التقسيم في حقه، وإنما ذكرنا ذلك لدفع طعن المتعنتين.
ثم ما بينه بالرأي إذا أقر عليه كان صوابا لا محالة فيثبت به علم اليقين، بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي، وهو نظير الالهام على ما أشرنا إليه في بيان الوحي الباطن، وأنه حجة قاطعة في حقه وإن كان الالهام في حق غيره لا يكون بهذه الصفة على ما نبينه في بابه.
والدليل على هذه القاعدة ما روي أن خولة رضي الله عنها لما جاءت إليه تسأله عن ظهار زوجها منها قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه فقالت: إني أشتكي إلى الله فأنزل الله تعالى قوله: (قد سمع الله قول التي تجادلك) الآية، فعرفنا أنه كان يفتي بالرأي في أحكام الشرع وكان لا يقر على الخطأ، وهذا لانا أمرنا باتباعه، قال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه) وحين بين بالرأي وأقر على ذلك كان اتباع ذلك فرضا علينا لا محالة، فعرفنا أن ذلك هو الحق المتيقن به، ومثل ذلك لا يوجد في حق الامة، فالمجتهد قد يخطئ ويقر على ذلك، فلهذا لم يكن الرأي في حق غيره موجبا علم اليقين ولا صالحا لنصب الحكم به ابتداء، بل لتعدية حكم النص إلى غير المنصوص عليه.
والدليل عليه أنه قد ثبت بالنص عمله بالرأي فيما لم يقر عليه، وربما عوتب على ذلك وربما لم يعاتب.
فمما عوتب عليه ما وقعت الاشارة إليه في قوله تعالى: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) وفي قوله تعالى: (عبس وتولى أن جاءه الاعمى) ومما لم يعاتب عليه ما يروى أنه
لما دخل بيته ووضع السلاح حين فرغ من حرب الاحزاب أتاه جبريل عليه السلام وقال: وضعت السلاح ولم تضعه الملائكة.
وأمره بأن يذهب إلى بني قريظة.
ومن ذلك أنه أمر أبا بكر رضي الله عنه بتبليغ سورة براءة إلى المشركين في العام الذي أمره فيه أن يحج بالناس، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: لا يبلغها إليهم إلا رجل منك.
فبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أثره ليكون هو المبلغ للسورة إليهم، والقصة في ذلك معروفة، فبهذا يتبين أنه كان يعمل برأيه، وكان لا يقر إلا على ما هو الصواب، ولهذا كان لا تجوز مخالفته في ذلك لانه حين أقر عليه فقد حصل التيقن بكون الصواب فيه، فلا يسع لاحد أن يخالفه في ذلك.
فأما قوله: (وما ينطق عن الهوى) فقد قيل: هذا فيما يتلو عليه من
القرآن، بدليل أول السورة قوله تعالى: (والنجم إذا هوى) : أي والقرآن إذا أنزل.
وقيل المراد بالهوى: هوى النفس الامارة بالسوء، وأحد لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع هوى النفس أو القول به، ولكن طريق الاستنباط والرأي غير هوى النفس.
وهذا أيضا تأويل قوله تعالى: (قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي) ثم في قوله: (إن أتبع إلا ما يوحى إلي) ما يوضح جميع ما قلنا، لان اتباع الوحي إنما يتم في العمل بما فيه الوحي بعينه، واستنباط المعنى فيه لاثبات الحكم في نظيره وذلك بالرأي يكون.
ثم قد بينا أنه ما كان يقر إلا على الصواب فإذا أقر على ذلك كان ذلك وحيا في المعنى وهو يشبه الوحي في الابتداء على ما بينا، إلا أنا شرطنا في ذلك أن ينقطع طمعه عن الوحي، وهو نظير ما يشترط في حق الامة للعمل بالرأي العرض على الكتاب والسنة، فإذا لم يوجد في ذلك فحينئذ يصار إلى اجتهاد الرأي.
ونظيره من الاحكام من كان في السفر ولا ماء معه وهو يرجو وجود الماء فعليه أن يطلب
الماء ولا يعجل بالتيمم، وإن كان لا يرجو وجود الماء فحينئذ يتيمم ولا يشتغل بالطلب، فحال غير رسول الله ممن يبتلى بحادثة كحال من لا يرجو وجود الماء، لانه لا طمع له في الوحي فلا يؤخر العمل بالرأي والاجتهاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي في كل ساعة عادة فكان حاله فيما يبتلى به من الحوادث كحال من يرجو وجود الماء، فلهذا كان ينتظر ولا يعجل بالعمل بالرأي، وكان هذا الانتظار في حقه بمنزلة التأمل في النص المؤول أو الخفي في حق غيره، ومدة الانتظار في ذلك أن ينقطع طمعه عن نزول الوحي فيه، بأن كان يخاف الفوت فحينئذ يعمل فيه بالرأي ويبينه للناس، فإذا أقر على ذلك كانت حجة قاطعة بمنزلة الثابت بالوحي.
فصل قال علماؤنا رحمهم الله: فعل النبي عليه السلام وقوله متى ورده وافقا لما هو في القرآن يجعل صادرا عن القرآن وبيانا لما فيه.
وأصحاب الشافعي يقولون: يجعل ذلك بيان حكم مبتدأ حتى يقوم الدليل على خلافه.
وعلى هذا قلنا: بيان النبي عليه السلام للتيمم في حق الجنب صادر عما في القرآن، وبه يتبين أن المراد من قوله تعالى: (أو لامستم النساء) الجماع دون المس باليد، وهم يجعلون ذلك بيان حكم مبتدأ ويحملون قوله (أو لامستم النساء) على المس باليد، قالوا: لانه يحتمل أن يكون ذلك صادرا عما في القرآن، ويحتمل أن يكون شرع الحكم ابتداء وهو في الظاهر غير متصل بالآية فيحمل على أنه بيان حكم مبتدأ باعتبار الظاهر، ولان في حمله على هذا زيادة فائدة، وفي حمله على ما قلتم تأكيد ما صار معلوما بالآية ببيانه فحمله على ما يفيد فائدة جديدة كان أولى.
وحجتنا فيه قوله تعالى: (إن هو إلا وحي يوحى) ففي هذا تنصيص على أن قوله وفعله في حكم الشرع يكون عن وحي، فإذا كان ذلك ظاهرا
معلوما في الوحي المتلو عرفنا أنه صادر عن ذلك، إذ لو لم نجعله صادرا عن ذلك احتجنا إلى إثبات وحي غير متلو فيه وإثبات الوحي من غير الحاجة ومع الشك لا يجوز.
وقال تعالى: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) : أي ردوه إلى كتاب الله وقال تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) فإذا ظهر منه حكم في حادثة وذلك الحكم موجود فيما أنزل الله عرفنا أنه حكم فيه بما أنزل الله لانه ما كان يخالف ما أمر به، ولان الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك من أفعاله، فإنهم حملوا قطعه يد السارق على الوجوب وأداءه الصلاة في مواقيتها على الوجوب، وقد بينا أن مطلق فعله لا يدل على ذلك، فلولا أنهم علموا أن فعله ذلك صادر عن الآيات الدالة على الوجوب نحو قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات) وقوله تعالى: (فاقطعوا أيديهما) لاستفسروه وطلبوا منه بيان صفة فعله، وحيث لم يشتغلوا بذلك عرفنا أنهم علموا أن فعله ذلك منه صادر عن الآية، فأما دعواهم الاحتمال
ساقط، فإن الظاهر أن ذلك منه صادر عن القرآن، لانه مأمور باتباع ما في القرآن كغيره.
وقال تعالى: (واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) فسقط اعتبار الاحتمال مع هذا الظاهر.
وقولهم: فيه زيادة فائدة، ساقط فإن إثبات هذه الزيادة لا يمكن إلا بعد إثبات وحي بالشك ومن غير حاجة إليه، وقد بينا أن ذلك لا يجوز.
فصل قال علماؤنا رحمهم الله: فعل النبي عليه السلام متى كان على وجه البيان لما في القرآن وحصل ذلك منه في مكان أو زمان فالبيان يكون واقعا بفعله وبما هو من صفاته عند الفعل، فأما المكان والزمان لا يكون شرطا فيه.
وأصحاب الشافعي يقولون: البيان منه بالمداومة على فعل مندوب إليه في مكان أو على
فعل واجب في مكان أو زمان يدل على أن ذلك المكان والزمان شرط فيه.
وعلى هذا قلنا: إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في أشهر الحج لا يكون بيانا في أن الاحرام تختص صحته بالوجود في أشهر الحج حتى يجوز الاحرام بالحج قبل أشهر الحج.
وكذلك فعله ركعتي الطواف في مقام إبراهيم لا يكون بيانا أن ركعتي الطواف تختص بالاداء في ذلك المكان.
وعلى قول الشافعي رحمه الله ينتصب الزمان شرطا ببيانه والمكان في أحد الوجهين أيضا، قال: لان مداومته على ذلك في مكان بعينه أو زمان بعينه لو لم يحمل على وجه البيان لم يبق له فائدة أخرى، وقد علمنا أنه ما داوم على ذلك إلا لفائدة، ثم قاس هذا بمداومته على فعل الصلوات المفروضة في الاوقات المخصوصة والامكنة الطاهرة، فإن ذلك بيان منه لوجوب مراعاة ذلك الزمان والمكان في أداء الفرائض، فكذلك في سائر أفعاله.
ولكنا نقول: البيان إنما يحصل بفعله والمكان والزمان ليس من فعله في شئ، فما كان المكان والزمان إلا بمنزلة فعل غيره، وغيره وإن ساعده على ذلك الفعل فإن البيان يكون حاصلا بفعله لا بفعل غيره،
فكذلك المكان الذي يوجد فيه الفعل أو الزمان الذي يوجد فيه الفعل لا يكون له حظ في حصول البيان به، بل بجعل البيان حاصلا بفعله فقط إلا أن يكون هناك أمر مجمل في حق الزمان محتاجا إلى البيان أو في حق المكان، كما في باب الصلاة فإنا نعلم فرضيتها في بعض الاوقات (المخصوصة) واختصاص جواز أدائها ببعض الامكنة بالنص فيكون فعله في الاوقات المخصوصة والامكنة الطاهرة بيانا للمجمل في ذلك كله، فأما فعله في باب الحج بيان لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت) وذلك حاصل بالفعل لا بالوقت، لانه ليس فيه أمر مجمل لاختصاص عقد الاحرام بالحج ببعض الاوقات دون البعض، وما كان
ذلك إلا نظير مباشرة الطهارة بالماء في الوقت، فإن ذلك كان بيانا منه لاصل الطهارة المأمور بها في الكتاب، ولم يكن بيانا في التخصيص في الوقت حتى تجوز الطهارة بالماء قبل دخول الوقت بلا خلاف.
فصل: في بيان شرائع من قبلنا اختلف العلماء في هذا الفصل على أقاويل.
فمنهم من قال: ما كان شريعة لنبي فهو باق أبدا حتى يقوم دليل النسخ فيه وكل من يأتي فعليه أن يعمل به على أنه شريعة ذلك النبي عليه السلام ما لم يظهر ناسخه.
وقال بعضهم: شريعة كل نبي تنتهي ببعث نبي آخر بعده حتى لا يعمل به إلا أن يقوم الدليل على بقائه وذلك ببيان من النبي المبعوث بعده.
وقال بعضهم: شرائع من قبلنا يلزمنا العمل به على أن ذلك شريعة لنبينا عليه السلام فيما لم يظهر دليل النسخ فيه، ولا يفصلون بين ما يصير معلوما من شرائع من قبلنا بنقل أهل الكتاب أو برواية المسلمين عما في أيديهم من الكتاب وبين ما ثبت من ذلك ببيان في القرآن أو السنة.
وأصح الاقاويل عندنا أن ما ثبت بكتاب الله أنه كان شريعة من قبلنا أو ببيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن علينا العمل به على أنه شريعة لنبينا عليه السلام ما لم يظهر ناسخه، فأما ما علم بنقل أهل الكتاب أو بفهم المسلمين
من كتبهم فإنه لا يجب اتباعه لقيام دليل موجب للعلم على أنهم حرفوا الكتب، فلا يعتبر نقلهم في ذلك لتوهم أن المنقول من جملة ما حرفوا، ولا يعتبر فهم المسلمين ذلك مما في أيديهم من الكتب لجواز أن يكون ذلك من جملة ما غيروا وبدلوا.
والدليل على أن المذهب هذا أن محمدا قد استدل في كتاب الشرب على جواز القسمة بطريق المهايأة في الشرب بقوله تعالى: (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم) وبقوله تعالى: (هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) وإنما
أخبر الله تعالى ذلك عن صالح عليه السلام، ومعلوم أنه ما استدل به إلا بعد اعتقاده بقاء ذلك الحكم شريعة لنبينا عليه السلام.
واستدل أبو يوسف على جريان القصاص بين الذكر والانثى بقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) وبه كان يستدل الكرخي على جريان القصاص بين الحر والعبد والمسلم والذمي، والشافعي في هذا لا يخالفنا، وقد استدل برجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين بحكم التوراة، كما نص عليه بقوله أنا أحق من أحيا سنة أماتوها على وجوب الرجم على أهل الكتاب وعلى أن ذلك صار شريعة لنبينا.
ونحن لا ننكر ذلك أيضا ولكنا ندعي انتساخ ذلك بطريق زيادة شرط الاحصان لايجاب الرجم في شريعتنا، ولمثل هذه الزيادة حكم النسخ عندنا.
وبين المتكلمين اختلاف في أن النبي عليه السلام قبل نزول الوحي (عليه) هل كان متعبدا بشريعة من قبله ؟ فمنهم من أبى ذلك، ومنهم من توقف فيه، ومنهم من قال كان متعبدا بذلك، ولكن موضع بيان هذا الفصل أصول التوحيد، فإنا نذكر ههنا ما يتصل بأصول الفقه.
فأما الفريق الاول قالوا: صفة الاطلاق في الشئ يقتضي التأبيد فيه إذا كان محتملا للتأبيد، فالتوقيت يكون زيادة فيه لا يجوز إثباته إلا بالدليل، ثم الرسول الذي كان الحكم شريعة له لم يخرج من أن يكون رسولا برسول آخر بعث بعده، فكذلك شريعته لا تخرج من أن تكون معمولا بها وإن بعث بعده رسول آخر ما لم يقم دليل النسخ فيه، ألا ترى أن علينا الاقرار بالرسل كلهم، وإلى ذلك وقعت الاشارة في قوله تعالى: (والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله) فكذلك ما ثبت شريعة لرسول فما لم يظهر ناسخه فهو بمنزلة ما ليس فيه احتمال النسخ في كونه باقيا معمولا به، يوضحه أن ما ثبت شريعة لرسول فقد ثبتت الحقية فيه وكونه مرضيا عند
الله، وبعث الرسل لبيان ما هو مرضي عند الله فما علم كونه مرضيا قبل بعث رسول آخر لا يخرج من أن يكون مرضيا ببعث رسول آخر، وإذا بقي مرضيا كان معمولا به كما كان قبل بعث الرسول الثاني، وبهذا تبين الفرق أن الاصل هو الموافقة في شرائع الرسل إلا أذا تبين تغيير حكم بدليل النسخ.
فأما الفريق الثاني فقد استدلوا بقوله تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) وبقوله: (وجعلناه هدى لبني إسرائيل) فتخصيص بني إسرائيل يكون التوراة هدى لهم يكون دليلا على أنه لا يلزمنا العمل بما فيه إلا أن يقوم دليل يوجب العمل به في شريعتنا، ولان بعث الرسل لبيان ما بالناس حاجة إلى بيانه، وإذا لم تجعل شريعة رسول منتهية ببعث رسول آخر لم يكن بالناس حاجة إلى البيان عند بعث الثاني، لان ذلك مبين عندهم بالطريق الموجب للعلم، فمن هذا الوجه يتبين أن بعث رسول آخر دليل النسخ لشريعة كانت قبله، ولهذا جعلنا هذا كالنسخ فيما يحتمل النسخ دون ما لا يحتمل النسخ أصلا كالتوحيد وأصل الدين، ألا ترى أن الرسل عليهم السلام ما اختلفوا في شئ من ذلك أصلا ولا وصفا ولا يجوز أن يكون بينهم فيه خلاف، ولهذا انقطع القول ببقاء شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لعلمنا بدليل مقطوع به أنه لا نبي بعده حتى يكون ناسخا لشريعته، يوضحه أن الانبياء عليهم السلام قبل نبينا أكثرهم إنما بعثوا إلى قوم مخصوصين ورسولنا هو المبعوث إلى الناس كافة على ما قال عليه السلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: بعثت إلى الاحمر والاسود، وقد كان النبي قبلي يبعث إلى قومه الحديث، فإذا ثبت أنه قد كان في المرسلين من يكون وجوب العمل بشريعته على أهل مكان دون أهل مكان آخر وإن كان ذلك مرضيا عند الله تعالى علمنا أنه يجوز أن يكون وجوب العمل به على أهل زمان دون أهل زمان آخر
وإن كان (ذلك) منتهيا ببعث نبي آخر وقد كان يجوز اجتماع نبيين في ذلك الوقت في مكانين على أن يدعو كل واحد منهما إلى شريعته، فعرفنا أنه يجوز مثل ذلك في زمانين وأن المبعوث آخرا يدعو إلى العمل بشريعته ويأمر الناس باتباعه ولا يدعو إلى العمل بشريعة من قبله، فتعين الكلام في نبينا فإنه كان يدعو الناس إلى اتباعه كما قال تعالى: (فاتبعوني يحببكم الله) وإنما يأمر بالعمل بشريعته فلو بقيت شرائع من قبلنا معمولا بها بعد مبعثه لدعا الناس إلى العمل بذلك، ولكان يجب عليه أن يعلم ذلك أصحابه ليتمكنوا من العمل به ولو فعل ذلك لنقل إلينا نقلا مستفيضا والمنقول إلينا منعه إياهم عن ذلك، فإنه روي أنه (عليه الصلاة والسلام (لما رأى صحيفة في يد عمر سأله عنها فقال: هي التوراة.
فغضب حتى احمرت وجنتاه وقال: أمتهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى ! والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وبهذا اللفظ يتبين أن الرسول المتقدم ببعث رسول آخر يكون كالواحد من أمته في لزوم اتباع شريعته لو كان حيا، وعليه دل كتاب الله كما قال تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به) فأخذ الميثاق عليهم بذلك من أبين الدلائل على أنهم بمنزلة أمة من بعث آخرا في وجوب اتباعه، وبهذا ظهر شرف نبينا عليه السلام فإنه لا نبي بعده فكان الكل ممن تقدم وممن تأخر في حكم المتبع له وهو بمنزلة القلب يطيعه الرأس ويتبعه الرجل.
والفريق الثالث استدلوا بهذا الكلام أيضا ولكن بطريق أن ما كان شريعة لمن قبلنا يصير شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم ، ومن تقدم في العمل به يكون متبعا له، وفي حكم العامل بشريعته من هذا الوجه، فإن الله تعالى قال: (ملة أبيكم إبراهيم) وقال تعالى (قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم) وقال تعالى (وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا) وما يكون منتهيا منسوخا
لا يكون متبعا، فبهذه النصوص يتبين أنه متبع، وأنه ملة إبراهيم فلم يبق
طريق سوى أن نقول قد صار ذلك شريعة لنبينا عليه السلام، ويجب على الناس العمل به بطريق أنه شريعة له حتى يقوم دليل نسخه في شريعته، ألا ترى أنه قد اجتمع نبيان في وقت واحد وفي مكان واحد فيمن قبلنا على أن كان أحدهما تبعا للآخر نحو هارون مع موسى، ولوط مع إبراهيم كما قال تعالى: (فآمن له لوط) فكانت الشريعة لاحدهما والآخر نبي مرسل وهو مأمور باتباعه والعمل بشريعته، ولا يجوز القول باجتماع نبيين في وقت واحد ومكان واحد على أن يكون لكل واحد منهما شريعة تخالف شريعة الآخر في وقت من الاوقات.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) ومعلوم أن الهدى في أصل الدين وأحكام الشرع جميعا.
فإن قيل: المراد به الامر بالاقتداء بهم في أصل الدين فإنه مبني على ما تقدم من قوله تعالى: (فلما جن عليه الليل) إلى قوله (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم) إلى قوله تعالى: (أولئك الذين هدى الله) والدليل عليه أنه قد كان في المذكورين من لم يكن نبيا فإنه قال (ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم) ومعلوم أن الامر بالاقتداء في أحكام الشرع لا يكون في غير الانبياء وإنما يكون ذلك في أصل الدين، ولانه قد كان في شرائعهم الناسخ والمنسوخ، فالامر باللاقتداء بهم في الاحكام على الاطلاق يكون آمرا بالعمل بشيئين مختلفين متضادين وذلك غير جائز.
قلنا: في الآية تنصيص على الاقتداء بهداهم وذلك يعم أصل الدين وأحكام الشرع، ألا ترى إلى قوله تعالى: (آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) أنه يدلنا على أن الهدى كل ما يجب الاتقاء فيه وما يكون المهتدي فيه متقيا، وقال تعالى:
(إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون) والحكم إنما يكون بالشرائع، ولما سئل مجاهد عن سجدة ص قال: سجدها داود وهو ممن أمر نبيكم بأن يقتدي به، وتلا قوله تعالى: (فبهداهم اقتده) فبهذا تبين أن هذا أمر مبتدأ غير مبني على ما سبق فعمومه يتناول أصل الدين والشرائع جميعا.
وقوله: فيها ناسخ ومنسوخ، قلنا: وفي شريعتنا أيضا ناسخ ومنسوخ ثم لم يمنع ذلك إطلاق القول بوجوب الاقتداء علينا برسول الله
صلى الله عليه وسلم في شريعته.
وقوله: قد كان فيهم من ليس بنبي، لا كذلك فقد ألحق به من البيان ما يعلم به أن المراد الانبياء وهو قوله تعالى: (واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب) مع أن الامر بالاقتداء يعلم أنه لا يتناول إلا من يعلم أنه مرضي الطريقة، مقتدي به من نبي أو ولي، والاولياء على طريقة الانبياء عليهم السلام في العمل بشرائعهم، فبهذا يتبين أن المراد هو الامر بالاقتداء بالانبياء عليهم السلام، ومعلوم أنه ما أمر بالاقتداء بهم في دعاء الناس إلى شريعتهم وإنما أمر بذلك على أن يدعو الناس إلى شريعته، فعرفنا بهذا أن ذلك كله صار شريعة له، بمنزلة الملك ينتقل من المورث إلى الوارث فيكون ذلك الملك بعينه مضافا إلى الوارث بعدما كان مضافا إلى المورث في حياته، وإلى ذلك وقعت الاشارة في قوله تعالى: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) فأما قوله: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) قد عرفنا يقينا أنه ليس المراد به المخالفة في المنهاج في الكل بل ذلك مراد في البعض وهو ما قام الدليل فيه على انتساخه.
وقوله: (هدى لبني إسرائيل) لا يدل على أنه ليس بهدى لغيرهم، كقوله تعالى: (هدى للمتقين) والقرآن
هدى للناس أجمع، وأيد هذا دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتوراة وطلب حكم الرجم منه للعمل به، وقوله: أنا أحق من أحيا سنة أماتوها فإن إحياء سنة أميتت إنما يكون بالعمل بها، فعرفنا أن التوراة هدى لبني إسرائيل ولغيرهم، وأيد جميع ما ذكرنا قوله تعالى: (مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) ولا معنى لذلك سوى أن ما فيه يصير شريعة لنبينا بما أنزل عليه من الكتاب إلا ما ثبت نسخه، وهذا هو القول الصحيح عندنا، إلا أنه قد ظهر من أهل الكتاب الحسد وإظهار العداوة مع المسلمين فلا يعتمد قولهم فيما يزعمون أنه من شريعتهم وأن ذلك قد انتقل إليهم بالتواتر، ولا تقبل شهادتهم في ذلك لثبوت كفرهم وضلالهم فلم يبق لثبوت ذلك طريق سوى نزول القرآن به أو بيان الرسول له، فما وجد فيه هذا الطريق فعلينا فيه الاتباع والعمل به حتى يقوم دليل
النسخ، وأيد ما ذكرنا قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) .
(فأولئك هم الظالمون) ومعلوم أنهم ما كانوا يمتنعون من العمل بأحكام التوراة وإنما كانوا يمتنعون من العمل به على طريق أنه شريعة رسولنا فإنهم كانوا لا يقرون برسالته وقد سماهم الله كافرين ظالمين ممتنعين من الحكم بما أنزل الله.
وكذلك قال تعالى: (وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) وإنما سماهم فاسقين لتركهم العمل بما في الانجيل على أنه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، فبهذا يتبين أن ذلك كله قد صار شريعة لنبينا عليه السلام وأنه يجب اتباعه والعمل به على أنه شريعة نبينا.
وفي قوله تعالى: (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله) تنصيص على أنه
معمول به.
وقال تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) إلى قوله: (أن أقيموا الدين) والدين اسم لكل ما يدان الله به فتدخل الاحكام في ذلك، ويظهر أن ذلك كله قد صار شريعة لنبينا فيجب اتباعه والعمل به إلا ما قام دليل النسخ فيه.
فصل: في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف حكى أبو عمرو بن دانيكا الطبري عن أبي سعيد البردعي رحمه الله أنه كان يقول: قول الواحد من الصحابة مقدم على القياس يترك القياس بقوله، وعلى هذا أدركنا مشايخنا.
وذكر أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله: أنه كان يقول: أرى أبا يوسف يقول في بعض مسائله: القياس كذا إلا أني تركته للاثر، وذلك الاثر قول واحد من الصحابة.
فهذه دلالة بينة من مذهبه على تقديم قول الصحابي على القياس.
قال: وأما أنا فلا يعجبني هذا المذهب.
وهذا الذي ذكره الكرخي عن أبي يوسف موجود في كثير من المسائل عن أصحابنا، فقد قالوا في المضمضة والاستنشاق: إنهما سنتان في القياس في الجنابة والوضوء جميعا تركنا
القياس لقول ابن عباس وقالوا في الدم إذا ظهر على رأس الجرح ولم يسل فهو ناقض للطهارة في القياس تركناه لقول ابن عباس، وقالوا في الاغماء: إذا كان يوما وليلة أو أقل فإنه يمنع قضاء الصلوات في القياس تركناه لفعل عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وقالوا في إقرار المريض لوارثه إنه جائز في القياس تركناه لقول ابن عمر رضي الله عنهما.
وقال: أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فيمن اشترى شيئا على أنه (إن) لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فالعقد فاسد في القياس تركناه لاثر يروى عن ابن عمر.
وقال أبو حنيفة: إعلام قدر رأس المال فيما يتعلق العقد على قدره شرط لجواز السلم بلغنا نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وخالفه
أبو يوسف ومحمد بالرأي.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ضاع العين في يد الاجير المشترك بما يمكن التحرز عنه فهو ضامن لاثر روي فيه عن علي رضي الله عنه.
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه، فأخذ بالرأي مع الرواية بخلافه عن علي.
وقال محمد: لا تطلق الحامل أكثر من واحدة للسنة بلغنا ذلك عن ابن مسعود وجابر رضي الله عنهما.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بالرأي: إنها تطلق ثلاثا للسنة.
فعرفنا أن عمل علمائنا بهذا في مسائلهم مختلف.
ول لشافعي في المسألة قولان كان يقول في القديم: يقدم قول الصحابي على القياس، وهو قول مالك، وفي الجديد كان يقول: يقدم القياس في العمل به على قول الواحد والاثنين من الصحابة، كما ذهب إليه الكرخي.
وبعض أهل الحديث يخصون بترك القياس في مقابلة قولهم الخلفاء الراشدين، ويستدلون بقوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وبقوله عليه السلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فظاهر الحديثين يقتضي وجوب اتباعهما وإن خالفهما غيرهما من الصحابة، ولكن يترك هذا الظاهر عند ظهور الخلاف بقيام الدليل، فبقي حال ظهور قولهما من غير مخالف لها على ما يقتضيه الظاهر.
وأما الكرخي فقد احتج بقوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الابصار) والاعتبار هو العمل بالقياس والرأي فيما لا نص فيه، وقال تعالى: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) يعني إلى الكتاب والسنة، وقد دل عليه
حديث معاذ حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم تقضي ؟ قال: بكتاب الله.
قال: فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال: بسنة رسول الله.
قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال: اجتهد رأيي.
فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله فهذا دليل على أنه ليس بعد الكتاب والسنة شئ يعمل به سوى الرأي.
قال: ولا حجة لكم في قوله عليه السلام: أصحابي كالنجوم بأيهم
اقتديتم اهتديتم لان المراد الاقتداء بهم في الجري على طريقهم في طلب الصواب في الاحكام لا في تقليدهم وقد كانت طريقتهم العمل بالرأي والاجتهاد، ألا ترى أنه شبههم بالنجوم وإنما يهتدي بالنجم من حيث الاستدلال به على الطريق بما يدل عليه لا أن نفس النجم يوجب ذلك، وهو تأويل قوله: اقتدوا بالذين من بعدي وعليكم بسنة الخلفاء من بعدي فإنه إنما يعني سلوك طريقهم في اعتبار الرأي والاجتهاد فيما لا نص فيه، وهذا هو المعنى، فقد ظهر من الصحابة الفتوى بالرأي ظهورا لا يمكن إنكاره، والرأي قد يخطئ فكان فتوى الواحد منهم محتملا مترددا بين الصواب والخطأ، ولا يجوز ترك الرأي بمثله كما لا يترك بقول التابعي، وكما لا يترك أحد المجتهدين في عصر رأيه بقول مجتهد آخر.
والدليل على أن الخطأ محتمل في فتواهم ما روي أن عمر سئل عن مسألة فأجاب فقال رجل: هذا هو الصواب.
فقال: والله ما يدري عمر أن هذا هو الصواب أو الخطأ ولكني لم آل عن الحق.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه فيما أجاب به في المفوضة: وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان.
فعرفنا أنه قد كان جهة الخطأ محتملا في فتواهم، ولا يقال هذا في إجماعهم موجود إذا صدر عن رأي ثم كان حجة، لان الرأي إذا تأيد بالاجماع تتعين جهة الصواب فيه بالنص، قال عليه السلام: إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة ألا ترى أن إجماع أهل كل عصر يجعل حجة بهذا الطريق وإن لم يكن قول الواحد منهم مقدما على الرأي في العمل به، ولانه لم يظهر منهم دعاء الناس إلى أقاويلهم، ولو كان قول الواحد منهم مقدما على الرأي لدعا الناس إلى قوله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى العمل بقوله، وكما كانت الصحابة تدعو الناس إلى العمل بالكتاب والسنة وإلى العمل
بإجماعهم فيما أجمعوا عليه، إذ الدعاء إلى الحجة واجب، ولان قول الواحد
منهم لو كان حجة لم يجز لغيره مخالفته بالرأي كالكتاب والسنة، وقد رأينا أن بعضهم يخالف بعضا برأيه فكان ذلك شبه الاتفاق منهم على أن قول الواحد منهم لا يكون مقدما على الرأي.
ولا يدخل على هذا إجماعهم، فإن مع بقاء الواحد منهم مخالفا لا ينعقد الاجماع، وبعد ما ثبت الاجماع باتفاقهم لو بدا لاحدهم فخالف لم يعتد بخلافه أيضا على ما بينا أن انقراض العصر ليس بشرط لثبوت حكم الاجماع، وأن مخالفة الاجماع بعد انعقاده كمخالفة النص.
وجه ما ذهب إليه أبو سعيد البردعي وهو الاصح أن فتوى الصحابي فيه احتمال الرواية عمن ينزل عليه الوحي، فقد ظهر من عادتهم أن من كان عنده نص فربما روى وربما أفتى على موافقة النص مطلقا من غير الرواية، ولا شك أن ما فيه احتمال السماع من صاحب الوحي فهو مقدم على محض الرأي، فمن هذا الوجه تقديم قول الصحابي على الرأي بمنزلة تقديم خبر الواحد على القياس، ولئن كان قوله صادرا عن الرأي فرأيهم أقوى من رأي غيرهم، لانهم شاهدوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الحوادث وشاهدوا الاحوال التي نزلت فيها النصوص والمحال التي تتغير باعتبارها الاحكام، فبهذه المعاني يترجح رأيهم على رأي من لم يشاهد شيئا من ذلك، وعند تعارض الرأيين إذا ظهر لاحدهما نوع ترجيح وجب الاخذ بذلك، فكذلك إذا وقع التعارض بين رأي الواحد منا ورأي الواحد منهم يجب تقديم رأيه على رأينا لزيادة قوة في رأيه، وهكذا نقول في المجتهدين في زماننا، فإن على أصل أبي حنيفة إذا كان عند مجتهد أن من يخالفه في الرأي أعلم بطريق الاجتهاد، وأنه مقدم عليه في العلم فإنه يدع رأيه لرأي من عرف زيادة قوة في اجتهاده، كما أن العامي يدع رأيه لرأي المفتي المجتهد لعلمه بأنه متقدم عليه فيما يفصل به بين الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، وعلى قول أبي يوسف
ومحمد لا يدع المجتهد في زماننا رأيه لرأي من هو مقدم عليه في الاجتهاد من أهل عصره لوجود المساواة بينهما في الحال وفي معرفة طريق الاجتهاد، ولكن هذا لا يوجد فيما بين المجتهد منا والمجتهد من الصحابة، فالتفاوت بينهما في الحال لا يخفى
وفي طريق العلم كذلك فهم قد شاهدوا أحوال من ينزل عليه الوحي وسمعوا منه، وإنما انتقل إلينا ذلك بخبرهم وليس الخبر كالمعاينة.
فإن قيل: أليس أن تأويل الصحابي للنص لا يكون مقدما على تأويل غيره ولم يعتبر فيه هذه الاحوال فكذلك في الفتوى بالرأي ؟ قلنا: لان التأويل يكون بالتأمل في وجوه اللغة ومعاني الكلام، ولا مزية لهم في ذلك الباب على غيرهم ممن يعرف من معاني اللسان مثل ذلك.
فأما الاجتهاد في الاحكام إنما يكون بالتأمل في النصوص التي هي أصل في أحكام الشرع، وذلك يختلف باختلاف الاحوال ولاجله تظهر لهم المزية بمشاهدة أحوال الخطاب على غيرهم ممن لم يشاهد، ولا يقال هذه أمور باطنة وإنما أمرنا ببناء الحكم على ما هو الظاهر، لان بناء الحكم على الظاهر مستقيم عندنا ولكن في موضع يتعذر اعتبارهما جميعا، فأما عند المقابلة لا إشكال أن اعتبار الظاهر والباطن جميعا يتقدم على مجرد اعتبار الظاهر (وفي الاخذ بقول الصحابي اعتبارهما وفي العمل بالرأي اعتبار الظاهر) فقط هذا مع ما لهم من الفضيلة بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه في الدين سماعا منه، وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالخيرية بعده وتقديمهم في ذلك على من بعدهم بقوله: خير الناس قرني الحديث، وقال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه فعرفنا أنهم يوفقون لاصابة الرأي ما لا يوفق غيرهم لمثله فيكون رأيهم أبعد عن احتمال الخطأ من رأي من بعدهم، ولا حجة في قوله تعالى: (فاعتبروا) لان تقديم قولهم بهذا الطريق نوع من الاعتبار فالاعتبار يكون بترجيح أحد الدليلين بزيادة قوة فيه،
وكذلك قوله تعالى: (فردوه إلى الله والرسول) لان في تقديم فتوى الصحابي رد الحكم إلى أمر الرسول عليه السلام، لان الرسول عليه السلام قد دعا الناس إلى الاقتداء بأصحابه بقوله بأيهم اقتديتم اهتديتم وإنما كان لا يدعو الواحد منهم غيره إلى قوله لان ذلك الغير إن أظهر قولا بخلاف قوله فعند تعارض القولين منهما تتحقق المساواة بينهما وليس أحدهما بأن يدعو صاحبه إلى قوله بأولى من الآخر، وإن لم يظهر منه قول بخلاف ذلك فهو لا يدري
لعله إذا دعاه إلى قوله أظهر خلافه فلا يكون قوله حجة عليه، فأما بعدما ظهر القول عن واحد منهم وانقرض عصرهم قبل أن يظهر قول بخلافه من غيره فقد انقطع احتمال ما ثبت به المساواة من الوجه الذي قررنا فيكون قوله حجة، وإنما ساغ لبعضهم مخالفة البعض لوجود المساواة بينهم فيما يتقوى به الرأي، وهو مشاهدة أحوال التنزيل ومعرفة أسبابه.
ولا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه، وذلك نحو المقادير التي لا تعرف بالرأي، فإنا أخذنا بقول علي رضي الله عنه في تقدير المهر بعشرة دراهم، وأخذنا بقول أنس في تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثره بعشرة أيام، وبقول عثمان بن أبي العاص في تقدير أكثر النفاس بأربعين يوما، وبقول عائشة رضي الله عنها في أن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين، وهذا لان أحدا لا يظن بهم المجازفة في القول، ولا يجوز أن يحمل قولهم في حكم الشرع على الكذب، فإن طريق الدين من النصوص إنما انتقل إلينا بروايتهم، وفي حمل قولهم على الكذب والباطل قول بفسقهم، وذلك يبطل روايتهم فلم يبق إلا الرأي أو السماع ممن ينزل عليه الوحي ولا مدخل
للرأي في هذا الباب، فتعين السماع وصار فتواه مطلقا كروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا شك أنه لو ذكر سماعه من رسول الله لكان ذلك حجة لاثبات الحكم به فكذلك إذا أفتى به ولا طريق لفتواه إلا السماع، ولهذا قلنا: إن قول الواحد منهم فيما لا يوافقه القياس يكون حجة في العمل به، كالنص يترك القياس به، حتى إن في شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن أخذنا بقول عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم رضي الله عنه وتركنا القياس، لان القياس لما كان مخالفا لقولها تعين جهة السماع في فتواها، وكذلك أخذنا بقول ابن عباس رضي الله عنهما في النذر بذبح الولد إنه يوجب ذبح شاة لانه قول يخالف القياس فتتعين فيه جهة السماع، وأخذنا بقول ابن
مسعود رضي الله عنه في تقدير الجعل لراد الآبق من مسيرة سفر بأربعين درهما، لانه قول بخلاف القياس وهو إطلاق الفتوى منه فيما لا يعرف بالقياس فتتعين جهة السماع.
فإن قيل: هذا المعنى يوجد في قول التابعي، فإنه لا يظن المجازفة في القول بالمجتهد في كل عصر، ولا يجوز حمل كلامه على الكذب قصدا، ومع ذلك لا تتعين جهة السماع لفتواه عند الاطلاق حتى لا يكون حجة فيما لا يستدرك بالقياس كما لا يكون حجة فيما يعرف بالقياس.
قلنا: قد بينا أن قول الصحابي يكون أبعد عن احتمال الغلط وقلة التأمل فيه من قول غيره، ثم احتمال اتصال قولهم بالسماع يكون بغير واسطة، فقد صحبوا من كان ينزل عليه الوحي وسمعوا منه، واحتمال اتصال قول من بعدهم بالسماع يكون بواسطة النقل وتلك الواسطة لا يمكن إثباتها بغير دليل وبدونها لا يثبت اتصال قوله بالسماع بوجه من الوجوه، فمن هذا الوجه
يقع الفرق بين قول الصحابي وبين قول من هو دونه فيما لا مدخل للقياس فيه.
فإن قيل: قد قلتم في المقادير بالرأي من غير أثر فيه، فإن أبا حنيفة قدر مدة البلوغ بالسن بثماني عشرة سنة أو سبع عشرة سنة بالرأي، وقدر مدة وجوب دفع المال إلى السفيه الذي لم يؤنس منه الرشد بخمس وعشرين سنة بالرأي، وقدر أبو يوسف ومحمد مدة تمكن الرجل من نفي الولد بأربعين يوما بالرأي، وقدر أصحابنا جميعا ما يطهر به البئر من النزح عند وقوع الفأرة فيه بعشرين دلوا، فهذا يتبين فساد قول من يقول إنه لا مدخل للرأي في معرفة المقادير، وأنه تتعين جهة السماع في ذلك إذا قاله صحابي.
قلنا: إنما أردنا بما قلنا المقادير التي تثبت لحق الله ابتداء دون مقدار يكون فيما يتردد بين القليل والكثير والصغير والكبير، فإن المقادير في الحدود والعبادات نحو أعداد الركعات في الصلوات مما لا يشكل على أحد أنه لا مدخل
للرأي في معرفة ذلك فكذلك ما يكون بتلك الصفة مما أشرنا إليه فأما ما استدللتم به فهو من باب الفرق بين القليل والكثير فيما يحتاج إليه، فإنا نعلم أن ابن عشر سنين لا يكون بالغا وأن ابن عشرين سنة يكون بالغا، ثم التردد فيما بين ذلك فيكون هذا استعمال الرأي في إزالة التردد، وهو نظير معرفة القيمة في المغصوب والمستهلك ومعرفة مهر المثل والتقدير في النفقة فإن للرأي مدخلا في معرفة ذلك من الوجه الذي قلنا، وكذلك حكم دفع المال إلى السفيه فإن الله تعالى قال (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) وقال: (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا) .
فوقعت الحاجة إلى معرفة الكبير على وجه يتيقن معه بنوع من الرشد وذلك مما يعرف بالرأي، فقدر أبو حنيفة ذلك بخمس وعشرين سنة
لانه يتوهم أن يصير جدا في هذه المدة، ومن صار فرعه أصلا فقد تناهى في الاصلية فيتيقن له بصفة الكبر ويعلم إيناس الرشد منه باعتبار أنه بلغ أشده، فإنه قيل في تفسير الاشد المذكور في سورة يوسف عليه السلام إنه هذه المدة، وكذلك ما قال أبو يوسف ومحمد فإنه يتمكن من النفي بعد الولادة بساعة أو ساعتين لا محالة ولا يتمكن من النفي بعد سنة أو أكثر، فإنما وقع التردد فيما بين القليل والكثير من المدة فاعتبر الرأي فيه بالبناء على أكثر مدة النفاس.
فأما حكم طهارة البئر بالنزح فإنما عرفناه بآثار الصحابة، فإن فتوى علي وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في ذلك معروفة، مع أن ذلك من باب الفرق بين القليل من النزح والكثير، وقد بينا أن للرأي مدخلا في معرفة هذا كله في قول ظهر عن صحابي ولم يشتهر ذلك في أقرانه، فإنه بعدما اشتهر إذا لم يظهر النكير عن أحد منهم كان ذلك بمنزلة الاجماع وقد بينا الكلام فيه، وما اختلف فيه الصحابة فقد بينا أن الحق لا يعدو أقاويلهم حتى لا يتمكن أحد من أن يقول بالرأي قولا خارجا عن أقاويلهم، وكذلك لا يشتغل بطلب التاريخ بين أقاويلهم ليجعل المتأخر ناسخا للمتقدم كما يفعل في الآيتين والخبرين، لانه لما ظهر الخلاف بينهم ولم نجز المحاجة بسماع من صاحب الوحي فقد انقطع احتمال التوقيف فيه وبقي مجرد القول بالرأي والرأي
لا يكون ناسخا للرأي، ولهذا لم يجز نسخ أحد القياسين بالآخر، ولكن طريق العمل طلب الترجيح بزيادة قوة لاحد الاقاويل، فإن ظهر ذلك وجب العمل بالراجح، وإن لم يظهر يتخير المبتلي بالحادثة في الاخذ بقول أيهما شاء بعد أن يقع في أكثر رأيه أنه هو الصواب، وبعد ما عمل بأحد القولين لا يكون له أن يعمل بالقول الآخر إلا بدليل، وقد بينا (لك) هذا في باب المعارضة.
هذا الذي بينا هو النهاية في الاخذ بالسنة حقيقتها وشبهتها ثم العمل بالرأي بعده، وبذلك يتم الفقه
على ما أشار إليه محمد بن الحسن في أدب القاضي فقال: لا يستقيم العمل بالحديث إلا بالرأي، ولا يستقيم العمل بالرأي إلا بالحديث.
وأصحابنا هم المتمسكون بالسنة والرأي في الحقيقة، فقد ظهر منهم من تعظيم السنة ما لم يظهر من غيرهم ممن يدعي أنه صاحب الحديث، لانهم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة لقوة درجتها، وجوزوا العمل بالمراسيل، وقدموا خبر المجهول على القياس، وقدموا قول الصحابي على القياس، لان فيه شبهة السماع من الوجه الذي قررنا، ثم بعد ذلك كله عملوا بالقياس الصحيح وهو المعنى الذي ظهر أثره بقوته.
فأما الشافعي رحمه الله حين لم يجوز العمل بالمراسيل فقد ترك كثيرا من السنن، وحين لم يقبل رواية المجهول فقد عطل بعض السنة أيضا، وحين لم ير تقليد الواحد من الصحابة فقد جوز الاعراض عما فيه شبهة السماع، ثم جوز العمل بقياس الشبه وهو مما لا يجوز أن يضاف إليه الوجوب بحال، فما حاله إلا كحال من لم يجوز العمل بالقياس أصلا، ثم يعمل باستصحاب الحال فحمله ما صار إليه من الاحتياط على العمل بلا دليل وترك العمل بالدليل.
وتبين أن أصحابنا هم القدوة في أحكام الشرع أصولها وفروعها، وأن بفتواهم اتضح الطريق للناس إلا أنه بحر عميق لا يسلكه كل سابح، ولا يستجمع شرائطه كل طالب، والله الموفق.
فصل: في خلاف التابعي هل يعتد به مع إجماع الصحابة لا خلاف أن قول التابعي لا يكون حجة على وجه يترك القياس بقوله، فقد روينا عن أبي حنيفة أنه كان يقول: ما جاءنا عن التابعين زاحمناهم.
ولا خلاف أن من لم يدرك عصر الصحابة من التابعين أنه لا يعتد بخلافه في إجماعهم، فأما من أدرك عصر الصحابة من التابعين كالحسن وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي رضي الله عنهم فإنه يعتد بقوله في إجماعهم عندنا حتى لا يتم إجماعهم مع خلافه،
وعلى قول الشافعي لا يعتد بقوله مع إجماعهم.
وعلى هذا قال أبو حنيفة لا يثبت إجماع الصحابة في الاشعار، لان إبراهيم النخعي كان يكرهه وهو ممن أدرك عصر الصحابة فلا يثبت إجماعهم دون قوله.
وجه قول الشافعي أن إجماع الصحابة حجة بطريق الكرامة لهم ولا مشاركة للتابعي معهم في السبب الذي استحقوا به زيادة الكرامة، وذلك صحبة رسول الله عليه السلام، ومشاهدة أحوال الوحي، ولهذا لم نجعل التابعي الذي أدرك عصرهم بمنزلتهم في الاحتجاج بقوله، فكذلك لا يقدح قوله في إجماعهم كما لا يقدح قول من لم يدرك عصر الصحابة في إجماعهم، ولان صاحب الشرع أمرنا بالاقتداء بهم، وندب إلى ذلك بقوله عليه السلام: بأيهم اقتديتم اهتديتم وهذا لا يوجد في حق التابعي وإن أدرك عصرهم فلا يكون مزاحما لهم، وإنما ينعدم انعقاد الاجماع بالمزاحم.
وحجتنا في ذلك أنه لما أدرك عصرهم وسوغوا له اجتهاد الرأي والمزاحمة معهم في الفتوى والحكم بخلاف رأيهم قد صار هو كواحد منهم فيما يبتني على اجتهاد الرأي، ثم الاجماع لا ينعقد مع خلاف واحد منهم، فكذلك لا ينعقد مع خلاف التابعي الذي أدرك عصرهم، لانه من علماء ذلك العصر، فشرط انعقاد الاجماع أن لا يكون أحد من أهل العصر مخالفا لهم.
وبيان هذا أن عمر وعليا رضي الله عنهما قلدا شريحا القضاء بعدما ظهر منه مخالفتهما في الرأي، وإنما قلداه القضاء ليحكم برأيه.
فإن قيل: لا كذلك، بل قلداه القضاء ليحكم بقولهما أو بقول بعض الصحابة
سواهما.
قلنا: قد روي أن عمر كتب إلى شريح: اقض بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله، فإن لم تجد فاجتهد برأيك.
فإن قيل: معنى قوله: (فاجتهد برأيك) في آرائنا وأقاويلنا.
قلنا:
هذه زيادة على النص وهي تنزل منزلة النسخ فلا يكون تأويلا، وقد صح أن عليا رضي الله عنه تحاكم إلى شريح وقضى عليه بخلاف رأيه في شهادة الولد لوالده ثم قلده القضاء في خلافته، وابن عباس رضي الله عنهما رجع إلى قول مسروق في النذر بذبح الولد فأوجب عليه شاة بعدما كان يوجب عليه مائة من الابل، وعمر رضي الله عنه أمر كعب بن سور أن يحكم برأيه بين الزوجين فجعل لها ليلة من أربع ليال وكان ذلك خلاف رأي عمر.
قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: تذاكرنا مع ابن عباس وأبي هريرة عدة مرات عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس: تعتد بأبعد الاجلين، وقلت: تعتد بوضع الحمل، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، وعن مسروق أن ابن عباس رضي الله عنهما صنع طعاما لاصحاب عبد الله بن مسعود فجرت المسائل، وكان ابن عباس يخطئ في بعض فتاويه فما منعهم من أن يردوا عليه إلا كونهم على طعامه.
وسئل ابن عمر عن مسألة فقال: سلوا عنها سعيد بن جبير فهو أعلم بها مني.
وكان أنس بن مالك إذا سئل عن مسألة فقال سلوا عنها مولانا الحسن.
فظهر أنهم سوغوا اجتهاد الرأي لمن أدرك عصرهم ولا معتبر بالصحبة في هذا الباب، ألا ترى أن إجماع أهل كل عصر حجة وإن انعدمت الصحبة لهم، وأنه قد كان في الصحابة الاعراب الذين لم يكونوا من أهل الاجتهاد في الاحكام فكان لا يعتبر قولهم في الاجماع مع وجود الصحبة، فعرفنا أن هذا الحكم إنما يبتنى على كونه من علماء العصر، وممن يجتهد في الاحكام ويعتد بقوله.
ثم الصحابة فيما بينهم كانوا متفاضلين في الدرجة،
فإن درجة الخلفاء الراشدين فوق درجة غيرهم في الفضيلة ولم يدل ذلك على أن الاجماع الذي هو حجة يثبت بدون قولهم، وكما أمر رسول الله بالاقتداء بالصحابة فقد أمر بالاقتداء بالخلفاء الراشدين لسائر الصحابة بقوله عليه السلام: عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء من بعدي وأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر بقوله عليه السلام: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ثم هذا لا يدل على أن إجماعهم يكون حجة قاطعة مع خلاف سائر الصحابة.
فصل: في حدوث الخلاف بعد الاجماع باعتبار معنى حادث فمذهب علمائنا أن الاتفاق متى حصل في شئ على حكم ثم حدث فيه معنى اختلفوا لاجله في حكمه، فالاجماع المتقدم لا يكون حجة فيه.
وقال بعض العلماء ذلك الاجماع حجة فيه يجب التمسك به حتى يوجد إجماع آخر بخلافه.
وبيان هذا في الماء الذي وقع فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه، فإن الاجماع الذي كان على طهارته قبل وقوع النجاسة فيه لا يكون حجة لاثبات صفة الطهارة فيه بعد وقوع النجاسة فيه، وعند بعضهم يكون حجة.
وكذلك المتيمم إذا أبصر الماء في خلال الصلاة فالاجماع المنعقد على صحة شروعه في الصلاة قبل أن يبصر الماء لا يكون حجة لبقاء صلاته بعدما أبصر الماء، وعند بعضهم يكون حجة.
وكذلك بيع أم الولد فالاجماع المنعقد على جواز بيعها قبل الاستيلاد لا يكون حجة لجواز بيعها بعد الاستيلاد عندنا، وعند بعضهم يكون حجة.
ويقولون: قد انعقد الاجماع على حكم في هذا العين فنحن على ما كنا عليه من الاجماع حتى ينعقد إجماع آخر له، لان الشئ لا يرفعه ما هو دونه ولا شك أن الخلاف دون الاجماع، يوضحه أن التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع، فإن النبي عليه السلام أمر الشاك في الحدث بأن لا ينصرف من صلاته حتى يستيقن بالحدث، لانه على يقين من الطهارة وهو في شك من الحدث.
وكذلك أمر الشاك في الصلاة بأن يأخذ بالاقل لكونه متيقنا به.
وكذلك في الاحكام نقول اليقين لا يزال بالشك حتى إذا شك في طلاق امرأته لم يقع الطلاق عليها.
وكذلك الاقرار بالمال لا يثبت مع الشك، لان براءة الذمة يقين باعتبار الاصل
فلا يزول المتيقن بالشك، وهذا لان اليقين كان معلوما في نفسه ومع الشك لا يثبت للعلم فلا يجوز ترك العمل بالعلم لاجل ما ليس بعلم.
وأصحابنا قالوا: هذا مذهب باطل، فإن الاجماع كان ثابتا في عين على حكم لا لانه عين وإنما كان ذلك لمعنى وقد حدث معنى آخر خلاف ذلك ومع هذا المعنى الحادث لم يكن الاجماع قط فكيف يستقيم استصحابه ؟ وبه نبطل نحن على ما كنا عليه، فإنا لم نكن على الاجماع مع هذا المعنى قط.
ثم لا يخلو: إما أن تكون الحجة نفس الاجماع، أو الدليل الذي نشأ منه الاجماع قبل حدوث هذا المعنى فيه، فإن كان نفس الاجماع فبعد الخلاف الاجماع، وفي الموضع الذي لا إجماع لا يتحقق الاحتجاج بنفس الاجماع وإن كان الدليل الذي نشأ منه الاجماع، فما لم يثبت بقاء ذلك الدليل بعد اعتراض المعنى الحادث لا يتحقق الاستدلال بالاجماع.
ثم يحتج عليهم بعين ما احتجوا به فنقول: قد تيقنا بالحدث المانع من جواز أداء الصلاة في أعضاء المحدث قبل استعمال هذا الماء الذي وقعت فيه النجاسة، فنحن على ما كنا عليه من اليقين، والاجماع لا يترك بالخلاف عند استعمال هذا الماء، واتفقنا على أن أداء الصلاة واجب على من أدرك الوقت فنحن على ذلك الاتفاق لا نتركه بأداء يكون منه بالتيمم بعدما أبصر الماء، لان سقوط الفرض بهذا الاداء مشكوك فيه، واتفقنا على أن الامة بعد ما حبلت من مولاها قد امتنع بيعها، فنحن على ذلك الاتفاق لا نتركه بالخلاف في جواز بيعها بعدما انفصل الولد عنها، وكل كلام يمكن أن يحتج به على الخصم بعينه في إثبات ما رام إبطاله به فهو باطل في نفسه، وهو نظير احتجاجنا على من يقول لا دليل على النافي في أحكام الشرع، وإنما الدليل على المثبت كما في الدعاوى، فإن البينة تكون على المثبت دون النافي، فنقول: من قال لا حكم فهو يثبت صحة اعتقاد نفي الحكم، وهذا منه إثبات حكم شرعي، وخصمه ينفي صحة هذا الاعتقاد فينبغي
أن تكون الحجة عليه للاثبات لا على خصمه فإنه ينفي، وسنقرر هذا الكلام في موضعه، ثم نستدل بقوله تعالى: (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) وفي هذا تنصيص على ترك العمل بما كان متيقنا به عند حدوث معنى
آخر وإن لم يكن ذلك المعنى متيقنا به، فإن كفرها قبل الهجرة كان متيقنا به وزوال ذلك بعد الهجرة إنما نعرفه بغالب الرأي لا باليقين، وليس هذا نظير ما استشهدوا به، لان هناك عند الشك في الطلاق لا نجد دليلا نعتمده في حكم الطلاق سوى ما تقدم، وكذلك عند الشك في وجوب المال لا نجد دليلا نعتمده سوى ما تقدم، وكذلك عند الشك في الحدث وعند الشك في أداء بعض الصلاة حتى إذا وجدنا فيه دليلا وهو التحري نقول بأنه يجب العمل بذلك الدليل، وهنا قد وجدنا دليلا نستدل به على الحكم بعد حدوث المعنى الحادث في العين فيجب العمل بذلك الدليل، ولا يجوز المصير إلى استصحاب ما كان قبل حدوث هذا المعنى، فاليقين إنما كان قبل وجود الدليل المغير، ومثله لا يكون يقينا بعد وجود الدليل المغير، وعلى هذا الاصل استصحاب العموم بعد حدوث الدليل المغير للحكم، فإنه لا يجوز لاحد أن يستدل على إباحة قتل المستأمن بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين) لان حكم هذا العام كان ثابتا قبل وجود الدليل المغير فلا يجوز الاستدلال به بعد ذلك في موضع فيه خلاف، وهو أن المستأمن إذا جعل نفسه طليعة للمشركين يخبرهم بعورات المسلمين فإنه لا يباح قتله استدلالا بقوله تعالى: (فاقلتوا المشركين) عندنا، وعند بعضهم يجوز قتله باعتبار هذه الحجة، والكلام في هذا مثل الكلام في الفصل الاول، والله أعلم.
باب القياس قال رضي الله عنه: مذهب الصحابة ومن بعدهم من التابعين والصالحين والماضين
من أئمة الدين رضوان الله عليهم جواز القياس بالرأي على الاصول التي تثبت أحكامها بالنص لتعدية حكم النص إلى الفروع جائز مستقيم يدان الله به، وهو مدرك من مدارك أحكام الشرع ولكنه غير صالح لاثبات الحكم به ابتداء، وعلى قول أصحاب الظواهر هو غير صالح لتعدية حكم النص به إلى ما لا نص فيه والعمل باطل أصلا في أحكام الشرع.
وأول من أحدث هذا القول إبراهيم النظام، وطعن في السلف لاحتجاجهم بالقياس ونسبهم بتهوره إلى خلاف ما وصفهم الله به، فخلع به ربقة الاسلام من عنقه، وكان ذلك منه إما للقصد إلى إفساد طريق المسلمين عليهم،
أو للجهل منه بفقه الشريعة، ثم تبعه على هذا القول بعض المتكلمين ببغداد، ولكنه تحرز عن الطعن في السلف فرارا من الشنعة التي لحقت النظام، فذكر طريقا آخر لاحتجاج الصحابة بالقياس هو دليل على جهله، وهو أنه قال: ما جرى بين الصحابة لم يكن على وجه الاحتجاج بالقياس وإنما كان على وجه الصلح والتوسط بين الخصوم وذكر المسائل لتقريب ما قصدوه من الصلح إلى الافهام.
وهذا مما لا يخفى فساده على من تأمل أدنى تأمل فيما نقل عن الصحابة في هذا الباب.
ثم نشأ بعده رجل متجاهل يقال له داود الاصبهاني فأبطل العمل بالقياس من غير أن وقف على ما هو مراد كل فريق ممن كان قبله، ولكنه أخذ طرفا من كل كلام ولم يشتغل بالتأمل فيه ليتبين له وجه فساده، قال: القياس لا يكون حجة، ولا يجوز العمل به في أحكام الشرع وتابعه على ذلك أصحاب الظواهر الذين كانوا مثله في ترك التأمل، وروى بعضهم هذا المذهب عن قتادة ومسروق وابن سيرين، وهو افتراء عليهم، فقد كانوا أجل من أن ينسب إليهم القصد إلى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما هو طريق أحكام الشرع بعد ما ثبت نقله عنهم.
ثم قال بعض نفاة القياس: دلائل العقل لا تصلح لمعرفة شئ من أمور الدين بها والقياس يشبه ذلك.
وقال بعضهم: لا يعمل بالدلائل العقلية في أحكام الشرع أصلا وإن كان يعمل بها في العقليات.
وقال بعضهم: لا يعمل بها إلا عند الضرورة ولا ضرورة في أحكام الشرع لامكان العمل بالاصل الذي هو استصحاب الحال.
وهذا أقرب أقاويلهم إلى القصد فيحتاج في تبين وجه الفساد فيه إلى إثبات أن القياس حجة أصلية في تعدية الاحكام لا حجة ضرورية، وإلى أنه مقدم في الاحتجاج به على استصحاب الحال.
ولكن نبدأ ببيان شبهتهم، فإنهم استدلوا بظاهر آيات من الكتاب، منها قوله تعالى: (أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) وفي المصير إلى الرأي لاثبات حكم في محل قول بأن الكتاب غير كاف.
وقال
تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ) وقال تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شئ) وقال تعالى: (ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) ففيها بيان أن الاشياء كلها في الكتاب إما في إشارته أو دلالته أو في اقتضائه أو في نصه، فإن لم يوجد في شئ من ذلك فبالابقاء على الاصل الذي علم ثبوته بالكتاب وهو دليل مستقيم، قال تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) الآية، فقد أمره بالاحتجاج بأصل الاباحة فيما لا يجد فيه دليل الحرمة في الكتاب، وهذا مستمر على أصل من يقول الاباحة في الاشياء أصل، وعلى أصلنا الذي نقول: إنما نعرف كل شئ بالكتاب، وهذا معلوم بقوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا) فإن الاضافة بلام التمليك تكون أدل على إثبات صفة الحل من التنصيص على الاباحة فلم يبق الرأي بعد هذا إلا لتعرف الحكمة والوقوف على المصلحة فيه عاقبة وذلك مما لا مجال للرأي في معرفته، فإن المصلحة في العاقبة عبارة عن الفوز والنجاة، وما به الفوز والنجاة
في الآخرة لا يمكن الوقوف عليه بالرأي، وإنما الرأي لمعرفة المصالح العاجلة التي يعلم جنسها بالحواس ثم نستدرك نظائرها بالرأي، وهذا مثل ما قلتم إن تعليل النصوص بعلة لا يتعدى إلى الفروع باطل، لانها خالية عن إثبات الحكم بها فالحكم في المنصوص ثابت بالنص فلا يكون في هذا التعليل إلا تعرف وجه الحكمة والوقوف على المصلحة في العاقبة والرأي لا يهتدي إلى ذلك.
ومنها قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) وقال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (الظالمون) (الفاسقون) والعمل بالرأي فيه تقدم بين يدي الله ورسوله وهو حكم بغير ما أنزل الله، فإن طريقة الاستنباط بآرائنا وما يبدو لنا من آرائنا لا يكون مما أنزل الله في شئ، إنما المنزل كتاب الله وسنة رسوله، فقد ثبت أنه ما كان ينطق إلا عن وحي، كما قال تعالى: (إن هو إلا وحي يوحى) وقال تعالى (لتبين للناس ما نزل إليهم) وإنما الحكم بالرأي من جملة ما قال الله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام) الآية، واستدلوا بآثار: فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: لم يزل بنو إسرائيل على طريقة مستقيمة حتى كثر فيهم أولاد السبايا، فقاسوا ما لم يكن بما
قد كان فضلوا وأضلوا وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعمل هذه الامة برهة بالكتاب ثم برهة بالسنة ثم برهة بالرأي، فإذا فعلوا ذلك ضلوا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين، أعيتهم السنة أن يحفظوها فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم وأرأيت وأرأيت ! فإنما هلك من كان قبلكم في أرأيت وأرأيت.
وقال النبي عليه السلام: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وإنما أراد به إعمال الرأي للعمل به في الاحكام، فإن إعمال الرأي للوقوف على معنى النص من حيث
اللسان فقه مستقيم، ويكون العمل به عملا بالنص لا بالرأي.
وبيان هذا فيما اختلف فيه ابن عباس وزيد رضي الله عنهم في زوج وأبوين فقال ابن عباس: للام ثلث جميع المال، فإن الله تعالى قال: (فلامه الثلث) والمفهوم من إطلاق هذه العبارة ثلث جميع المال.
وقال زيد: للام ثلث ما بقي، لان في الآية بيان أن للام ثلث ما ورثه الابوان، فإنه قال: (وورثه أبواه فلامه الثلث) وميراث الابوين هو الباقي بعد نصيب الزوج فللام ثلث ذلك.
هذا ونحوه عمل بالكتاب لا بالرأي فيكون مستقيما.
ومن حيث المعقول يستدلون بأنواع من الكلام: أحدها من حيث الدليل وهو أن في القياس شبهة في أصله، لان الوصف الذي تعدى به الحكم غير منصوص عليه ولا هو ثابت بإشارة النص ولا بدلالته ولا بمقتضاه، فتعيينه من بين سائر الاوصاف بالرأي لا ينفك عن شبهة، والحكم الثابت به من إيجاب أو إسقاط أو تحليل أو تحريم محض حق الله تعالى، ولا وجه لاثبات ما هو حق الله بطريق فيه شبهة، لان من له الحق موصوف بكمال القدرة يتعالى عن أن ينتسب إليه العجز أو الحاجة إلى إثبات حقه بما فيه شبهة، ولا وجه لانكار هذه الشبهة فيه، فإن القياس لا يوجب العلم قطعا بالاتفاق وكان ذلك باعتبار أصله، وعلى هذا التقرير يكون هذا استدلالا بقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) وبقوله تعالى: (ولا تقولوا على الله إلا الحق) ولا يدخل على هذا أخبار الآحاد، فإن
أصله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجب للعلم قطعا، وإنما تتمكن الشبهة في طريق الانتقال إلينا، وقد كان قول رسول الله حجة قبل الانتقال إلينا بهذا الطريق، فلشبهة تتمكن في الطريق لا يخرج الحديث من أن يكون حجة موجبة للعلم، وهو كالنص المؤول، فإن الشبهة تتمكن في تأويلنا، فلا يخرج النص
من أن يكون حجة موجبة للعلم.
ومنهم من قرر هذا الكلام من وجه آخر وقال: تعيين وصف في المنصوص بالرأي لاضافة الحكم إليه يشبه قياس إبليس لعنه الله على ما أخبر الله تعالى عنه: (أأسجد لمن خلقت طينا) وكذلك التمييز بين هذا الوصف وسائر الاوصاف في إثبات حكم الشرع أو الترجيح بالرأي يشبه ما فعله إبليس كما أخبر الله تعالى عنه: (خلقتني من نار وخلقته من طين) فلا يشك أحد في أن ذلك كان باطلا ولم يكن حجة، فالعمل بالرأي في أحكام الشرع لا يكون عملا بالحجة أيضا.
ونوع آخر من حيث المدلول فإنه طاعة لله تعالى ولا مدخل للرأي في معرفة ما هو طاعة لله، ولهذا لا يجوز إثبات أصل العبادة بالرأي، وهذا لان الطاعة في إظهار العبودية والانقياد، وما كان التعبد مبنيا على قضية الرأي بل طريقه طريق الابتلاء، ألا ترى أن من المشروعات ما لا يستدرك بالرأي (أصلا) كالمقادير في العقوبات والعبادات، ومنه ما هو خلاف ما يقتضيه الرأي وما هذه صفته فإنه لا يمكن معرفته بالرأي فيكون العمل بالرأي فيه عملا بالجهالة لا بالعلم، وكيف يمكن إعمال الرأي فيه والمشروعات متباينة في أنفسها يظهر ذلك عند التأمل في جميعها، والقياس عبارة عن رد الشئ إلى نظيره، يقال: قس النعل بالنعل: أي احذه به.
فكيف يتأتى هذا مع التباين ؟ يوضحه أن العلل التي تعدى الحكم بها من المنصوص عليه إلى غيره متعددة مختلفة ولاجلها اختلف العلماء في طريق التعدية، وما يكون بهذه الصفة فإنه يتعذر تعيين واحد منها للعمل إلا بما يوجب العلم قطعا وهو النص، ولهذا جوزنا العمل بالعلة المنصوص عليها، كما في قوله عليه السلام: الهرة ليست بنجسة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات فأثبتنا هذا الحكم في غيرها من حشرات البيت لان العلة
منصوص عليها، فأما بالرأي فلا يمكن الوقوف على ما هو العلة عينا فيكون العمل به
باطلا.
ولا يدخل عليه الاخبار فإنه لا اختلاف فيها في الاصل، لانه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينا أنه قال ذلك عن وحي، وقد علمنا بالنص أنه لا اختلاف فيما هو من عند الله، قال تعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وإنما الاختلاف في الاخبار من جهة الرواة، والحجة هو الخبر لا الراوي.
وما كان الاختلاف فيما بين الرواة إلا نظير اشتباه الناسخ من المنسوخ في كتاب الله فإن ذلك متى ارتفع بما هو الطريق في معرفته يكون العمل بالناسخ واجبا.
ويكون ذلك عملا بالنص لا بالتاريخ، فكذلك في الاخبار.
وتحت ما قررنا فائدتان بهما قوام الدين ونجاة المؤمنين: إحداهما المحافظة على نصوص الشريعة، فإنها قوالب الاحكام.
والثاني التبحر في معاني اللسان فإن معانيه جمة غائرة لا يفضل عمر المرء عن التأمل فيها إذا أراد الوقوف عليها، ولا يتفرغ للعمل بالهوى الذي ينشأ منه الزيغ عن الحق والوقوع في البدعة، وما يحصل به التحرز عن البدع واجبا أحكام الشرع فلا شك أن قوام الدين ونجاة المؤمنين يكون فيه.
ولا يدخل على شئ مما ذكرنا إعمال الرأي في أمر الحرب وقيم المتلفات ومهر النساء والوقوف على جهة الكعبة.
أما على الوجه الاول فلان هذا كله من حقوق العباد، ويليق بحالهم العجز والاشتباه فيما يعود إلى مصالحهم العاجلة فيعتبر فيه الوسع ليتيسر عليهم الوصول إلى مقاصدهم، وهذا في غير أمر القبلة ظاهر وكذلك في أمر القبلة، فإن الاصل فيه معرفة جهات أقاليم الارض وذلك من حقوق العباد.
وعلى الثاني فلان الاصل فيما هو من حقوق العباد ما يكون مستدركا بالحواس، وبه يثبت علم اليقين كما ثبت بالكتاب والسنة، ألا ترى أن الكعبة جهتها تكون محسوسة في حق من عاينها، وبعد البعد منها بإعمال الرأي يمكن تصييرها كالمحسوسة.
وكذلك أمر الحرب، فالمقصود صيانة النفس عما يتلفها أو قهر الخصم وأصل ذلك محسوس، وما هو إلا نظير التوقي
عن تناول سم الزعاف لعلمه أنه متلف، والتوقي عن الوقوع على السيف
والسكين لعلمه أنه ناقض للبنية، فعرفنا أن أصل ذلك محسوس، فإعمال الرأي فيه للعمل يكون في معنى العمل بما لا شبهة في أصله.
ثم في هذه المواضع الضرورة تتحقق إلى إعمال الرأي، فإنه عند الاعراض عنه لا نجد طريقا آخر وهو دليل العمل به، فلاجل الضرورة جوزنا به العمل بالرأي فيه، وهنا الضرورة لا تدعو إلى ذلك لوجود دليل في أحكام الشرع للعمل به على وجه يغنيه عن إعمال الرأي فيه وهو اعتبار الاصل الذي قررنا.
ولا يدخل على شئ مما ذكرنا إعمال الرأي والتفكر في أحوال القرون الماضية وما لحقهم من المثلات والكرامات، لان ذلك من حقوق العباد، فالمقصود أن يمتنعوا مما كان مهلكا لمن قبلهم حتى لا يهلكوا، أو أن يباشروا ما كان سببا لاستحقاق الكرامة لمن قبلهم حتى ينالوا مثل ذلك، وهو في الاصل من حقوق العباد بمنزلة الاكل الذي يكتسب به المرء سبب إبقاء نفسه، وإتيان الاناث في محل الحرث بطريقه ليكتسب به سبب إبقاء النسل.
ثم طريق ذلك الاعتبار بالتأمل في معاني اللسان، فإن أصله الخبر وذلك مما يعلم بحاسة السمع، ثم بالتأمل فيه يدرك المقصود وليس ذلك من حكم الشريعة في شئ، فقد كان الوقوف على معاني اللغة في الجاهلية وهو باق اليوم بين الكفرة الذين لا يعلمون حكم الشريعة.
وعلى هذا يخرج أيضا ما أمر به رسول الله عليه السلام من المشورة مع أصحابه، فإن المراد أمر الحرب وما هو من حقوق العباد، ألا ترى أن المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شاورهم في ذلك ولم ينقل أنه شاورهم قط في حقيقة ما هم عليه ولا فيما أمرهم به من أحكام الشرع، وإلى هذا المعنى أشار بقوله عليه السلام: إذا أتيتكم بشئ من أمر دينكم فاعملوا به، وإذا أتيتكم بشئ من أمر دنياكم فأنتم أعلم
بأمر دنياكم أو كلاما هذا معناه.
وهذا بيان شبه الخصوم في المسألة.
والحجة لجمهور العلماء دلائل الكتاب والسنة والمعقول، وهي كثيرة جدا قد أورد أكثرها المتقدمون من مشايخنا، ولكنا نذكر من كل نوع طرفا مما هو أقوى في الاعتماد عليه.
فمن دلائل الكتاب قوله تعالى (فاعتبروا يا أولي الابصار) حكي عن ثعلب قال: الاعتبار في اللغة هو: رد حكم الشئ إلى نظيره ومنه يسمى الاصل الذي يرد إليه النظائر عبرة، ومن ذلك قوله تعالى (إن في ذلك لعبرة لاولي الابصار) والرجل يقول: اعتبرت هذا الثوب بهذا الثوب أي سويته به في التقدير، وهذا هو حد القياس، فظهر أنه مأمور به بهذا النص.
وقيل الاعتبار: التبيين ومنه قوله تعالى: (إن كنتم للرؤيا تعبرون) : أي تبينون، والتبيين الذي يكون مضافا إلينا هو إعمال الرأي في معنى المنصوص ليتبين به الحكم في نظيره.
فإن قيل: الاعتبار هو التأمل والتفكر فيما أخبر الله تعالى مما صنعه بالقرون الماضية.
قلنا: هذا مثله ولكنه غير مأمور به لعينه بل ليعتبر حاله بحالهم فيزجروا عما استوجبوا به ما استوجبوا من العقاب، إذ المقصود من الاعتبار هو أن يتعظ بالعبرة، ومنه يقال السعيد من وعظ بغيره.
وبيان ما قلنا في القصاص، فإن الله تعالى يقول: (ولكم في القصاص حياة) وهو في العيان ضد الحياة، ولكن فيه حياة بطريق الاعتبار في شرعه واستبقائه، أما الحياة في شرعه وهو أن من قصد قتل غيره فإذا تفكر في نفسه أنه متى قتله قتل به انزجر عن قتله فتكون حياة لهما، والحياة في استبقائه أن القاتل عمدا يصير حربا لاولياء القتيل لخوفه على نفسه منهم، فالظاهر أنه يقصد قتلهم ويستعين على ذلك بأمثاله من السفهاء ليزيل
الخوف عن نفسه، فإذا استوفى الولي القصاص منه اندفع شره عنه وعن عشيرته فيكون حياة لهم من هذا الوجه، لان إحياء الحي في دفع سبب الهلاك عنه، قال تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) وإذا تبين هذا المعنى فنقول: لا فرق بين حكم هو هلاك في محل باعتبار معنى هو كفر، وبين حكم هو تحريم أو تحليل في محل باعتبار معنى هو قدر وجنس، فالتنصيص على الامر بالاعتبار في أحد الموضعين يكون تنصيصا على الامر به في الموضع الآخر.
فإن قيل: الكفر في كونه علة لما استوجبوه منصوص عليه، وكذلك القتل في كونه علة للقصاص، ونحن لا ننكر هذا الاعتبار في العلة التي هي منصوصة
فذلك نحو ما روي أن ماعزا رضي الله عنه زنا وهو محصن فرجم، فإنا نثبت هذا الحكم بالزنا بعد الاحصان في حق غير ماعز، وإنما ننكر هذا في علة مستنبطة بالرأي نحو الكيل والجنس فإنكم تجعلونه علة الربا في الحنطة بالرأي، إذ ليس في نص الربا ما يوجب تعيين هذا الوصف من بين سائر أوصاف المحل دلالة ولا إشارة.
قلنا: نحن لا نثبت حكم الربا في الفروع بعلة القدر والجنس إلا من الوجه الذي ثبت حكم الرجم في حق غير ماعز بعلة الزنا بعد الاحصان، فإن ماعزا إحصانه كان موجودا قبل الزنا ثم لما ظهر منه الزنا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إحصانه فلما ظهر إحصانه عنده أمر برجمه، فعرفنا يقينا أن علة ما أمر به هو ما ظهر عنده، والزنا يصلح أن يكون علة لذلك، لان المأمور به عقوبة والزنا جريمة يستوجب بها العقوبة، والاحصان لا يصلح أن يكون علة، لانها خصال حميدة، وبها يستفيد المرء كمال الحال وتتم عليه النعمة، فلا يصلح علة للعقوبة، ولكن تتغلظ الجناية بالزنا بعد وجودها، لان بحسب زيادة النعمة يزداد غلظ الجريمة، ألا ترى أن الله تعالى هدد نساء رسوله بضعف ما هدد به سائر النساء فقال تعالى: (من يأت منكن بفاحشة) الآية وكان
ذلك لزيادة النعمة عليهن، وبتغلظ الجريمة تتغلظ العقوبة فيصير رجما بعد أن كان جلدا في حق غير المحصن، فعرفنا أن الاحصان حال في الزاني يصير الزنا باعتباره موجبا للرجم فكان شرطا، وبمثل هذا الطريق تثبت علة الربا في موضع النص ثم تعدى الحكم به إلى الفروع، فإن النص قوله عليه السلام: الحنطة بالحنطة: أي بيعها، وقوله: مثل بمثل تفسير على معنى أنه إنما يكون بيعا في حال ما يكون مثلا بمثل (والفضل ربا): أي حراما بسبب الربا، فيثبت بالنص أن الفضل محرم، وقد علمنا أنه ليس المراد كل فصل، فالبيع ما شرع إلا للاستفضال والاسترباح، وإنما المراد الفضل الخالي عن العوض، لان البيع المشروع المعاوضة فلا يجوز أن يستحق به فضلا خاليا عن العوض، ثم خلو الفضل عن العوض لا يظهر يقينا بعدد الحبات والحفنات، ولا يظهر إلا بعد ثبوت المساواة قطعا في الوصف الذي صار به محلا للبيع وهو المالية، وهذه المساواة إنما يتوصل إلى معرفتها شرعا وعرفا، والشرع إنما أثبت هذه المساواة
بالكيل لا بالحبات والحفنات، فإنه قال: (كيلا بكيل) وكذلك في عرف التجار إنما يطلب المساواة بين الحنطة والحنطة بالكيل، وعند الاتلاف يجب ضمان المثل بالنص ويعتبر ذلك بالكيل، فثبت بهذا الطريق أن العلة الموجبة للحرمة ما يكون مؤثرا في المساواة حتى يظهر بعده الفضل الخالي عن المقابلة فيكون حراما، بمنزلة سائر الاشياء التي لها طول وعرض إذا قوبل واحد بآخر وبقي فضل في أحد الجانبين يكون خاليا عن المقابلة.
ثم المساواة من حيث الذات لا تعرف إلا بالجنس، ومن حيث القدر على الوجه الذي هو معتبر شرعا وعرفا.
لا يعرف إلا بالكيل، وهذه المساواة لا يتيقن إلا بعد سقوط قيمة الجودة، فأسقطنا قيمة الجودة منها عند المقابلة بجنسها
بالنص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (جيدها ورديئها سواء) وبدليل شرعي وهو حرمة الاعتياض عنها بالنص، فإنه لو باع قفيز حنطة جيدة بقفيز حنطة رديئة ودرهم على أن يكون الدرهم بمقابلة الجودة لا يجوز، وما يكون مالا متقوما يجوز الاعتياض عنه شرعا إلا أن إسقاط قيمة الجودة يكون شرطا لا علة، لانه لا تأثير لها في إحداث المساواة في المحل، والحكم الثابت بالنص وجوب المساواة، فكان بمنزلة الاحصان لايجاب الرجم، والمساواة التي هي الحكم لما كان يثبت بالقدر والجنس عرفنا أن هذين الوصفين هما العلة، وقد وجد التنصيص عليها في حديث الربا بمنزلة الزنا فإنه منصوص عليه في حديث ماعز، وهو مؤثر في إيجاب الحكم، فعرفنا أنه علة فيه، ثم بعد ما ثبت المساواة قطعا في صفة المالية باعتبار القدر إذا كان في أحد الجانبين فضل فهو خال عن العوض فيكون ربا حراما لا يجوز أن يكون مستحقا بالبيع، وإذا جعل مشروطا في البيع يفسد به البيع، وهذا فضل ظهر شرعا، ولو ظهر شرطا بأن باع من آخر عبدا بعبد على أن يسلم إليه مع ذلك ثوبا قد عينه من غير أن يكون بمقابلة الثوب عوض فإنه لا يجوز ذلك البيع، فكذلك إذا ثبت شرعا، ألا ترى أنه لما ثبت شرعا استحقاق صفة السلامة عن العيب بمطلق البيع فإذا فات ذلك يثبت حق الرد، بمنزلة ما هو ثابت شرطا بأن يشتري عبدا على
أنه كاتب فيجده غير كاتب، وبهذا تبين أن ما صرنا إليه هو الاعتبار المأمور به، فإنه تأمل في معنى النصوص لاضافة الحكم إلى الوصف الذي هو مؤثر فيه، بمنزلة إضافة الهلاك إلى الكفر الذي هو مؤثر فيه، والرجم إلى الزنا الذي هو مؤثر فيه، وكل عاقل يعرف أن قوام أموره بمثل هذا الرأي، فالآدمي ما سخر غيره ممن في الارض إلا بهذا الرأي، وما ظهر التفاوت بينهم في الامور العاجلة إلا بالتفاوت في
هذا الرأي فالمنكر له يكون متعنتا.
ومنها قوله تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) والاستنباط ليس إلا استخراج المعنى من المنصوص بالرأي.
وقيل المراد بأولي الامر أمراء السرايا، وقيل المراد العلماء وهو الاظهر، فإن أمراء السرايا إنما يستنبطون بالرأي إذا كانوا علماء، واستنباط المعنى من المنصوص بالرأي إما أن يكون مطلوبا لتعدية حكمه إلى نظائره وهو عين القياس، أو ليحصل به طمأنينة القلب وطمأنينة القلب إنما تحصل بالوقوف على المعنى الذي لاجله ثبت الحكم في المنصوص، وهذا لان الله تعالى جعل هذه الشريعة نورا وشرحا للصدور فقال: (أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه) والقلب يرى الغائب بالتأمل فيه، كما أن العين ترى الحاضر بالنظر إليه، ألا ترى أن الله تعالى قال في بيان حال من ترك التأمل: (فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) ثم في رؤية العين لا إشكال أنه يحصل به من الطمأنينة فوق ما يحصل بالخبر، وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس الخبر كالمعاينة ونحن نعلم أن الضال عن الطريق (العادل) يكون ضيق الصدر، فإذا أخبره مخبر بالطريق واعتقد الصدق في خبره يتبين في صدره بعض الانشراح، وإنما يتم انشراح صدره إذا عاين أعلام الطريق العادل، فكذلك في رؤية القلب، فإنه إذا تأمل في المعنى المنصوص حتى وقف عليه يتم به انشراح صدره، وتتحقق طمأنينة قلبه، وذلك بالنور الذي جعله الله في قلب كل مسلم، فالمنع من هذا التأمل والامر بالوقوف على مواضع النص من غير طلب المعنى فيه يكون نوع حجر ورفعا
لتحقيق معنى انشراح الصدر وطمأنينة القلب الثابت بقوله تعالى: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) .
فإن قيل: كيف يستقيم هذا وعندكم القياس لا يوجب العلم والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب ؟ قلنا: نعم ولكن يحصل له بالاجتهاد العلم من طريق الظاهر على وجه يطمئن قلبه وإن كان لا يدرك ما هو الحق باجتهاده لا محالة، فهو نظير قوله تعالى: (فإن علمتموهن مؤمنات) فإن المراد به العلم من حيث الظاهر.
فإن قيل: كيف يستقيم هذا وأكثر المشروعات بخلاف المعهود المعتاد بين الناس ؟ قلنا: نعم هو بخلاف المعهود المعتاد عند اتباع هوى النفس وإشارتها، وأما إذا ترك ذلك ورجع إلى ما ينبغي للعاقل أن يرجع إليه فإنه يكون ذلك موافقا لما هو المعهود المعتاد عند العقلاء، فباعتبار هذا التأمل يحصل البيان على وجه يطمئن القلب إليه في الانتهاء، واعتقاد الحقية في النصوص فرض حق، وطلب طمأنينة القلب فيه حسن كما أخبر الله تعالى عن الخليل صلوات الله عليه: (قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) .
ومنها قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) فقد بينا أن المراد به القياس الصحيح، والرجوع إليه عند المنازعة، وفيه بيان أن الرجوع إليه يكون بأمر الله وأمر الرسول.
ولا يجوز أن يقال المراد هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، لانه علق ذلك بالمنازعة، والامر بالعمل بالكتاب والسنة غير متعلق بشرط المنازعة، ولان المنازعة بين المؤمنين في أحكام الشرع قلما تقع فيما فيه نص من كتاب أو سنة، فعرفنا أن المراد به المنازعة فيما ليس في عينه نص، وأن المراد هو الامر بالرد إلى الكتاب والسنة بطريق التأمل فيما هو مثل ذلك الشئ من المنصوص، وإنما تعرف هذه المماثلة بإعمال الرأي وطلب المعنى فيه.
ثم الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في هذا
الباب أكثر من أن تحصى، وأشهر من أن تخفى.
فوجه من ذلك ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق المقايسة، على ما روي أنه قال لعمر حين سأله عن القبلة في حالة الصوم: أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك ؟ وهذا تعليم المقايسة فإن بالقبلة يفتتح طريق اقتضاء الشهوة، ولا يحصل بعينه اقتضاء الشهوة، كما أن بإدخال الماء في الفم يفتتح طريق الشرب ولا يحصل به الشرب.
وقال للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه ؟ فقالت: نعم، قال: فدين الله أحق وهذا تعليم المقايسة وبيان بطريق إعمال الرأي.
وقال للذي سأله عن قضاء رمضان متفرقا، أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم والدرهمين أكان يقبل منك ؟ قال: نعم، فقال: الله أحق بالتجاوز وقال للمستحاضة: إنه دم عرق انفجر فتوضئي لكل صلاة فهذا تعليم للمقايسة بطريق أن النجس لما سال حتى صار ظاهرا ووجب غسل ذلك الموضع للتطهير وجب تطهير أعضاء الوضوء به.
وقال عليه السلام: الهرة ليست بنجسة لانها من الطوافين عليكم والطوافات وهذا تعليم للمقايسة باعتبار الوصف الذي هو مؤثر في الحكم فإن الطوف مؤثر في معنى التخفيف، ودفع صفة النجاسة لاجل عموم البلوى والضرورة، فظهر أنه علمنا القياس والعمل بالرأي كما علمنا أحكام الشرع، ومعلوم أنه ما علمنا ذلك لنعمل به في معارضة النصوص، فعرفنا أنه علمنا ذلك لنعمل به فيما لا نص فيه.
ووجه آخر أنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك، فإنه قال لمعاذ رضي الله عنه حين وجهه إلى اليمن: بم تقضي ؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال: بسنة رسول الله.
قال فإن لم
تجد في سنة رسول الله ؟ قال: اجتهد رأيي.
قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله وقال لابي موسى رضي الله عنه حين وجهه إلى اليمين: اقض بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله، فإن لم تجد فاجتهد رأيك وقال لعمرو بن العاص رضي الله عنه: اقض بين هذين قال: على ماذا أقضي ؟ فقال على أنك إن اجتهدت فأصبت
فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة فلو لم يكن اجتهاد الرأي فيما لا نص فيه مدركا من مدارك أحكام الشرع لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرته.
ووجه آخر أنه عليه السلام كان يشاور أصحابه في أمور الحرب تارة، وفي أحكام الشرع تارة، ألا ترى أنه شاورهم في أمر الاذان والقصة فيه معروفة، وشاورهم في مفاداة الاسارى يوم بدر حتى أشار أبو بكر رضي الله عنه عليه بالفداء وأشار عمر رضي الله عنه بالقتل فاستحسن ما أشار به كل واحد منهما برأيه حتى شبه أبا بكر في ذلك بإبراهيم من الانبياء حيث قال: (ومن عصاني فإنك غفور رحيم) وبميكائيل من الملائكة فإنه ينزل بالرحمة، وشبه عمر بنوح من الانبياء عليهم السلام حيث قال: (لا تذر على الارض من الكافرين ديارا) وبجبريل من الملائكة فإنه ينزل بالعذاب، ثم مال إلى رأي أبي بكر.
فإن قيل: ففي ذلك نزل قوله: (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم) الآية، ولو كان مستحسنا لما عوتبوا عليه.
قلنا: العتاب ما كان في المشورة بل فيما نص الله عليه بقوله: (لمسكم فيما أخذتم) ثم هذا إنما يلزم من يقول إن كل مجتهد مصيب ونحن لا نقول بهذا، ولكن نقول إعمال
الرأي والمشورة مستحسن، ثم المجتهد قد يخطئ وقد يصيب كما في هذه الحادثة، فقد شاورهما رسول الله واجتهد كل واحد منهم رأيه، ثم أصاب أحدهما دون الآخر، وبهذا تبين أن قوله: (وشاورهم في الامر) ليس في الحرب خاصة، ولكن يتناول كل ما يتأتى فيه إعمال الرأي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر رضي الله عنهما يوما وقد شاورهما في شئ: قولا فإني فيما لم يوح إلي مثلكما وقد تركهم رسول الله على المشاورة بعده في أمر الخلافة حين لم ينص على أحد بعينه مع علمه أنه لا بد لهم من ذلك، ولما شاوروا فيه تكلم كل واحد برأيه إلى أن استقر الامر على ما قاله عمر بطريق المقايسة والرأي، فإنه قال: ألا ترضون لامر
دنياكم بمن رضي به رسول الله لامر دينكم.
يعني الامامة للصلاة، واتفقوا على رأيه، وأمر الخلافة من أهم ما يترتب عليه أحكام الشرع، وقد اتفقوا على جواز العمل فيه بطريق القياس، ولا معنى لقول من يقول إن كان هذا قياسا فهو منتقض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس ولم يكن ذلك دليل كونه خليفة بعده، وذلك لان عمر رضي الله عنه أشار إلى الاستدلال على وجه لا يرد هذا النقض وهو أنه في حال توفر الصحابة وحضور جماعتهم ووقوع الحاجة إلى الاستخلاف، خص أبا بكر بأن يصلي بالناس بعدما راجعوه في ذلك وسموا له غيره، كل هذا قد صار معلوما بإشارة كلامه وإن لم ينص عليه، ولم يوجد ذلك في حق عبد الرحمن ولا في حق غيره.
ثم عمر جعل الامر شورى بعده بين ستة نفر، فاتفقوا بالرأي على أن يجعلوا الامر في التعيين إلى عبد الرحمن بعدما أخرج نفسه منها فعرض على علي أن يعمل برأي أبى بكر وعمر فقال:
أعمل بكتاب الله، وبسنة رسول الله، ثم أجتهد رأيي، وعرض على عثمان هذا الشرط أيضا فرضي به فقلده، وإنما كان ذلك منه عملا بالرأي لانه علم أن الناس قد استحسنوا سيرة العمرين، فتبين بهذا أن العمل بالرأي كان مشهورا متفقا عليه بين الصحابة، ثم محاجتهم بالرأي في المسائل لا تخفى على أحد، فإنهم تكلموا في مسألة الجد مع الاخوة، وشبهه بعضهم بواد يتشعب منه نهر، وبعضهم بشجرة تنبت غصنا، وقد بينا ذلك في فروع الفقه.
وكذلك اختلفوا في العول وفي التشريك فقال كل واحد منهم فيه بالرأي، وبالرأي اعترضوا على قول عمر رضي الله عنه في عدم التشريك حين قالوا: هب أن أبانا كان حمارا، حتى رجع عمر إلى التشريك، فعرفنا أنهم كانوا مجمعين على جواز العمل بالرأي فيما لا نص فيه، وكفى بإجماعهم حجة.
فإن قيل: كيف يستقيم هذا وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله تعالى برأيي.
وقال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي.
وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم وأرأيت
وأرأيت.
قلنا: أما القول بالرأي عن أبي بكر رضي الله عنه فهو أشهر من أن يمكن إنكاره، لانه قال في الكلالة: أقول قولا برأيي، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان.
وما رووا عنه قد اختلفت فيه الرواية فقال في بعضها: إذا قلت في كتاب الله تعالى بخلاف ما أراد الله.
ولئن ثبت ما رووا فإنما استبعد قوله بالرأي فيما فيه نص بخلاف النص، وهذا لا يجوز منه ولا من غيره ولا يظن به.
وأما عمر رضي الله عنه: فالقول عنه بالرأي أشهر من الشمس، وبه يتبين أن مراده بذم الرأي عند مخالفة النص أو الاعراض
عن النص فيما فيه نص والاشتغال بالرأي الذي فيه موافقة هوى النفس، وإلى ذلك أشار في قوله: أعيتهم السنة أن يحفظوها.
والقول بالرأي عن علي رضي الله عنه مشهور، فإنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر على حرمة بيع أمهات الاولاد ثم رأيت أن أرقهن.
وبهذا يتبين أن مراده بقوله: لو كان الدين بالرأي: أصل موضوع الشرع، وبه نقول، فإن أصل أحكام الشرع غير مبني على الرأي ولهذا لا يجوز إثبات الحكم به ابتداء.
وقد اشتهر القول بالرأي عن ابن مسعود حيث قال في المفوضة: أجتهد رأيي.
فعرفنا أن مراده ذم السؤال على وجه التعنت بعدما يتبين الحق أو التكلف فيما لا يحتاج المرء إليه، وهو نظير قوله عليه السلام: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم والآثار التي ذكرها محمد في أول أدب القاضي كلها دليل على أنهم (كانوا) مجمعين على العمل بالرأي، فإنه بدأ بحديث عمر حين كتب إلى أبي موسى: اعرف الامثال والاشباه وقس الامور عند ذلك.
وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد أتى علينا زمان لسنا نسأل ولسنا هنالك.
الحديث.
فاتضح بما ذكرنا اتفاقهم على العمل بالرأي في أحكام الشرع.
فأما من طعن في السلف من نفاة القياس لاحتجاجهم بالرأي في الاحكام فكلامه كما قال الله تعالى: (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا)
* لان الله تعالى أثنى عليهم في غير موضع من كتابه كما قال تعالى: (محمد رسول الله والذين معه) الآية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم خير الناس فقال: خير الناس قرني الذين أنا فيهم والشريعة إنما بلغتنا بنقلهم، فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للاسلام دواؤه السيف إن لم يتب.
ومن قال منهم إن القول بالرأي كان من الصحابة على طريق التوسط والصلح
دون إلزام الحكم فهو مكابر جاحد لما هو معلوم ضرورة، لان الذين نقلوا إلينا ما احتجوا به من الرأي في الاحكام قوم عالمون عارفون بالفرق بين القضاء والصلح فلا يظن بهم أنهم أطلقوا لفظ القضاء فيما كان طريقه طريق الصلح بأن لم يعرفوا الفرق بينهما أو قصدوا التلبيس، ولا ينكر أنه كان في ذلك ما هو بطريق الصلح، كما قال ابن مسعود حين تحاكم إليه الاعرابي مع عثمان: أرى أن يأتي هذا واديه فيعطي به ثم إبلا مثل إبله وفصلانا مثل فصلانه.
فرضي بذلك عثمان.
وفي قوله فرضي به، بيان أن هذا كان بطريق الصلح، فعرفنا أن فيما لم يذكر مثل هذا اللفظ أو ذكر لفظ القضاء والحكم فالمراد به الالزام، وقد كان بعض ذلك على سبيل الفتوى، والمفتي في زماننا يبين الحكم للمستفتي ولا يدعوه إلى الصلح إلا نادرا، فكذلك في ذلك الوقت، وقد كان بعض ذلك بيانا فيما لم يكن فيه خصومة أولا تجري فيه الخصومة كالعبادات والطلاق والعتاق، نحو اختلافهم في ألفاظ الكنايات، واعتبار عدد الطلاق بالرجال والنساء وما أشبه ذلك، فعرفنا أن قول من قال لم يكن ذلك منهم إلا بطريق الصلح والتوسط، منكر من القول وزور.
ومنهم من قال: كانوا مخصوصين بجواز العمل والفتوى بالرأي كرامة لهم، كما كان رسول الله مخصوصا بأن قوله موجب للعلم قطعا، ألا ترى أنه قد ظهر منهم العمل فيما فيه نص بخلاف النص بالرأي وبالاتفاق ذلك غير جائز لاحد بعدهم، فعرفنا أنهم كانوا مخصوصين بذلك.
وبيان هذا فيما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لصلح بين الانصار فأذن بلال وأقام فتقدم أبو بكر رضي الله عنه للصلاة، فجاء رسول الله وهو في الصلاة - الحديث، إلى أن قال:
فأشار على أبي بكر أن أثبت في مكانك، ورفع أبو بكر رضي الله عنه يديه
وحمد الله ثم استأخر وتقدم رسول الله، وكانت سنة الامامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم معلوما بالنص، ثم تقدم أبو بكر بالرأي، وقد أمره أن يثبت في مكانه نصا، ثم استأخر بالرأي.
ولما أراد رسول الله أن يتقدم للصلاة على ابن أبي المنافق جذب عمر رضي الله عنه رداءه، وفي رواية استقبله وجعل يمنعه من الصلاة عليه والاستغفار له وكان ذلك منه بالرأي، ثم نزل القرآن على موافقة رأيه، يعني قوله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) ولما أراد علي أن يكتب كتاب الصلح عام الحديبية كتب: هذا ما صالح محمد رسول الله وسهيل بن عمرو على أهل مكة.
قال سهيل: لو عرفناك رسولا ما حاربناك، اكتب محمد بن عبد الله، فأمر رسول الله عليا أن يمحو رسول الله فأبى علي رضي الله عنه ذلك حتى أمره أن يريه موضعه فمحاه رسول الله بيده وكان هذا الاباء من علي بالرأي في مقابلة النص.
وقد كان الحكم للمسبوق أن يبدأ بقضاء ما سبق به ثم يتابع الامام، حتى جاء معاذ يوما وقد سبقه رسول الله ببعض الصلاة فتابعه فيما بقي ثم قضى ما فاته، فقال له رسول الله: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: وجدتك على شئ فكرهت أن أخالفك عليه.
فقال: سن لكم معاذ سنة حسنة فاستنوا بها وكان هذا منه عملا بالرأي في موضع النص ثم استصوبه رسول الله في ذلك.
وأبو ذر حين بعثه رسول الله مع إبل الصدقة إلى البادية أصابته جنابة فصلى صلوات بغير طهارة إلى أن جاء إلى رسول الله الحديث إلى أن قال له: التراب كافيك ولو إلى عشر حجج ما لم تجد الماء وكان ذلك منه عملا بالرأي في موضع النص.
وكذلك عمرو بن العاص أصابته جنابة في ليلة باردة فتيمم وأم أصحابه مع وجود الماء وكان ذلك منه عملا بالرأي في موضع النص ثم لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فعرفنا أنهم كانوا مخصوصين بذلك.
وكذلك ظهر منهم الفتوى بالرأي فيما لا يعرف بالرأي
من المقادير نحو حد الشرب كما قال علي رضي الله عنه فإنه ثبت بآرائنا.
ولا وجه لذلك إلى الحمل على معنى الخصوصية.
والجواب أن نقول: هذا الكلام عند التأمل فيه من جنس الطعن عليهم لا بيان الكرامة لهم، لان كرامتهم إنما تكون بطاعة الله وطاعة رسوله، فالسعي لاظهار مخالفة منهم في أمر الله وأمر الرسول يكون طعنا فيهم، ومعلوم أن رسول الله ما وصفهم بأنهم خير الناس إلا بعد علمه بأنهم أطوع الناس له، وأظهر الناس انقيادا لامره وتعظيما لاحكام الشرع، ولو جاز إثبات مخالفة الامر بالرأي لهم بطريق الكرامة والاختصاص بناء على الخيرية التي وصفهم بها رسول الله لجاز مثل ذلك لمن بعدهم بناء على ما وصفهم الله به بقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) الآية، ولو جاز ذلك في فتاويهم لجاز فيما نقلوا إلينا من أحكام الشرع، فتبين أن هذا من جنس الطعن، وأنه لا بد من طلب التأويل فيما كان منهم في صورة الخلاف ظاهرا بما هو تعظيم وموافقة في الحقيقة.
ووجه ذلك بطريق الفقه أن نقول: قد كان من الامور ما فيه احتمال معنى الرخصة والاكرام أو معنى العزيمة والالزام، ففهموا أن ما اقترن به من دلالة الحال أو غيره مما يتبين به أحد المحتملين، ثم رأوا التمسك بما هو العزيمة أولى لهم من الترخص بالرخصة، وهذا أصل في أحكام الشرع.
وبيان هذا في حديث الصديق، فإن إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأن يثبت في مكانه كان محتملا معنى الاكرام له ومعنى الالزام، وعلم بدلالة الحال أنه على سبيل الترخص والاكرام له، فحمد الله تعالى على ذلك، ثم تأخر تمسكا بالعزيمة الثابتة بقوله تعالى: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) وإليه أشار بقوله: ما كان لابن
أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وكذلك كان تقدمه للامامة قبل أن يحضر رسول الله، فإن التأخير إلى أن يحضر كان رخصة، ومراعاة حق الله في أداء الصلاة في الوقت المعهود كان عزيمة، فإنما قصد التمسك بما هو العزيمة لعلمه أن رسول الله عليه السلام كان يستحسن ذلك منه، فعرفنا أنه ما قصد إلا تعظيم أمر الله وتعظيم رسول الله فيما باشره
بالرأي.
وكذلك فعل عمر رضي الله عنه بالامتناع من الصلاة على من شهد الله بكفره وهو العزيمة، لان الصلاة على الميت المسلم يكون إكراما له وذلك لا يشك فيه إذا كان المصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا أن التقدم للصلاة عليه كان بطريق حسن العشرة، ومراعاة قلوب المؤمنين من قراباته، فجذب عمر رداءه تمسكا بما هو العزيمة، وتعظيما لرسول الله لا قصدا منه إلى مخالفته.
وكذلك حديث علي فإنه أبى أن يمحو ذلك تعظيما لرسول الله وهو العزيمة، وقد علم أن رسول الله ما قصد بما أمر به إلا تتميم الصلح لما رأى فيه من الحظ للمسلمين بفراغ قلوبهم، ولو علم علي أن ذلك كان أمرا بطريق الالزام لمحاه من ساعته، ألا ترى أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك ستبعثني في أمر أفأكون فيه كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ فقال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فبهذا تبين أنه عرف بأن ذلك الامر منه لم يكن إلزاما ورأى إظهار الصلابة في الدين بمحضر من المشركين عزيمة فتمسك به، ثم الرغبة في الصلح مندوب إليه الامام بشرط أن يكون فيه منفعة للمسلمين، وتمام هذه المنفعة في أن يظهر الامام المسامحة والمساهلة معهم فيما يطلبون، ويظهر المسلمون القوة والشدة في ذلك، ليعلم العدو أنهم لا يرغبون في الصلح لضعفهم، فلاجل هذا فعل علي رضي
الله عنه ما فعله، وكأنه تأويل قوله تعالى: (ولا تهنوا ولا تحزنوا) وكذلك حديث معاذ رضي الله عنه، فإن السنة التي كانت في حق المسبوق من البداية بما فاته، فيها احتمال معنى الرخصة ليكون الاداء عليه أيسر، فوقف معاذ على ذلك وعرف أن العزيمة متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واعتقاد الغنيمة فيما أدركه معه، فاشتغل بإحراز ذلك أولا تمسكا بالعزيمة لا مخالفة للنص.
وكذلك حديث أبي ذر إن صح أنه أدى صلاته في تلك الحالة بغير طهارة، فإن في حكم التيمم للجنب بعض الاشتباه في النص باعتبار القراءتين (أو لامستم) (أو لامستم النساء) فلعله كان عنده أن
المراد المس باليد وأنه لا يجوز التيمم للجنب كما هو مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، ثم رأى أن بسبب العجز يسقط عنه فرض الطهارة في الوقت، وأن أداء الصلاة في الوقت عزيمة، فاشتغل بالاداء تعظيما لامر الله وتمسكا بالعزيمة.
وكذلك حديث عمرو بن العاص، فإنه رأى أن فرض الاغتسال ساقط عنه لما يلحقه من الحرج بسبب البرد أو لخوفه الهلاك على نفسه، وقد ثبت بالنص أن التيمم مشروع لدفع الحرج، فعرفنا أنه ليس في شئ من هذه الآثار معنى يوهم مخالفة النص من أحد منهم، وأنهم في تعظيم رسول الله كما وصفهم الله به.
وأما حد الشرب فإنما أثبتوه استدلالا بحد القذف، على ما روي أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر: يا أمير المؤمنين إذا شرب هذي وإذا هذي افترى، وحد المفترين في كتاب الله ثمانون جلدة.
ثم الحكم الثابت بالاجماع لا يكون محالا به على الرأي، وقد بينا أن الاجماع يوجب علم اليقين والرأي لا يوجب ذلك، ثم هذا دعوى الخصوصية من غير دليل، ومن لا يرى إثبات شئ بالقياس
فكيف يرى إثبات مجرد الدعوى من غير دليل والكتاب يشهد بخلاف ذلك، فالناس في تكليف الاعتبار المذكور في قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الابصار) سواء، وهم كانوا أحق بهذا الوصف، وهذا أقوى ما نعتمده من الدليل المعقول في هذه المسألة، فإنه لا فرق بين التأمل في إشارات النص فيما أخبر الله به عن الذين لحقهم المثلات بسبب كفرهم كما قال تعالى: (هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب) الآية، لنعتبر بذلك وننزجر عن مثل ذلك السبب، وبين التأمل في إشارات النص في حديث الربا ليعرف به أن المحرم هو الفضل الخالي عن العوض، فثبت ذلك الحكم بعينه في كل محل يتحقق فيه الفضل الخالي عن العوض مشروطا في البيع كالارز والسمسم والجص وما أشبه ذلك وقد قررنا هذا، يوضحه أن التأمل في معنى النص الثابت بإشارة صاحب الشرع بمنزلة التأمل في معنى اللسان
الثابت بوضع واضع اللغة، ثم التأمل في ذلك للوقوف على طريق الاستعارة حتى يجعل ذلك اللفظ مستعارا في محل آخر بطريقه، جائز مستقيم من عمل الراسخين في العلم، فكذلك التأمل في معاني النص لاثبات حكم النص في كل موضع علم أنه مثل المنصوص عليه، وهذا لنوعين من الكلام: أحدهما أن الله تعالى نص على أن القرآن تبيان لكل شئ بقوله تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ) ولا يتمكن أحد من أن يقول كل شئ في القرآن باسمه الموضوع له في اللغة، فعرفنا أنه تبيان لكل شئ بمعناه الذي يستدرك به حكمه، وما ثبت بالنص فإما أن يقال هو ثابت بصورة النص لا غير، أو بالمعنى الذي صار معلوما بإشارة النص، والاول باطل، فإن الله تعالى قال: (فلا تقل لهما أف) ثم أحد لا يقول إن هذا نهي عن صورة التأفيف
دون الشتم والضرب.
وكذلك قوله تعالى: (ولا يظلمون نقيرا) وقوله تعالى: (من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار) فعرفنا أن ثبوت الحكم باعتبار المعنى الذي وقعت الاشارة إليه في النص.
ثم ذلك المعنى نوعان: جلي، وخفي، ويوقف على الجلي باعتبار الظاهر، ولا يوقف على الخفي إلا بزيادة التأمل وهو المراد بقوله: (فاعتبروا) وبعدما ثبت لزوم اعتبار ذلك المعنى بالنص وإثبات الحكم في كل محل قد وجد فيه ذلك المعنى يكون إثباتا بالنص لا بالرأي وإن لم يكن صيغة النص متناولا، إلا ترى أن الحكم بالرجم على ماعز لم يكن حكما على غيره باعتبار صورته ولكن باعتبار المعنى الذي لاجله توجه الحكم عليه بالرجم كان ذلك بيانا في حق سائر الاشخاص بالنص.
والثاني أنه ما من حادثة إلا وفيها حكم لله تعالى من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو إسقاط، ومعلوم أن كل حادثة لا يوجد فيها نص، فالنصوص معدودة متناهية ولا نهاية لما يقع من الحوادث إلى قيام الساعة، وفي تسميته حادثة إشارة إلى أنه لا نص فيها، فإن ما فيه النص يكون أصلا معهودا.
وكذلك الصحابة ما اشتغلوا باعتماد نص في كل حادثة (طلبا أو رواية، فعرفنا أنه لا يوجد نص في كل حادثة)
وقد لزمنا معرفة حكم الحادثة بالحجة بحسب الوسع فإما أن يكون الحجة استنباط المعنى من النصوص، أو استصحاب الحال كما قالوا، ومعلوم أنه ليس في استصحاب الحال إلا عمل بلا دليل ولا دليل جهل، والجهل لا يصلح أن يكون حجة باعتبار الاصل، وهو أيضا مما لا يوقف عليه، فمن المحتمل أن لا يكون عند بعض الناس فيه دليل ويكون عند بعضهم، والقياس من الوجه الذي قررنا حجة وإن كان لا يوجب علم اليقين، ألا ترى أن الشرع جوز لنا الاقدام على المباحات لقصد تحصيل المنفعة، يعني المسافرة للتجارة والمحاربة للعدو والغلبة على الاعداء
بغالب الرأي، والاجتهاد في أمر القبلة والاشتغال بالمعالجة لتحصيل صفة البرء، وكل ذلك إقدام من غير بناء على ما يوجب علم اليقين، ثم هو حسن في بعض المواضع واجب في بعض المواضع.
وكذلك تقويم المتلفات، واعتقاد المعروف في النفقات والمتعة، فإن ذلك منصوص عليه، ثم الاقدام عليه بالرأي جائز فكان ذلك عملا بالحجة، فتبين أن القياس من نوع العمل بما هو حجة في الاصل ولكنه دون الثابت من الحكم بالنص، فلا يصار إليه إلا في وضع لا يوجد فيه نظر.
فأما استصحاب الحال فهو عمل بالجهل فلا يجوز المصير إليه إلا عند الضرورة المحضة بمنزلة تناول الميتة.
وسنقرر هذا في بابه إن شاء الله تعالى.
فبهم التقرير يتبين أن نفاة القياس يتمسكون بالجهل، وأن فقهاء الامصار يعلمون بما هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال.
وأما استدلالهم بقوله تعالى: (أو لم يكفهم ؟) قلنا نحن نقول بأن ما أنزل من الكتاب كذلك ولكن الاحتجاج بالقياس مما أنزل في الكتاب إشارة وإن كان لا يوجد فيه نصا فإنه الاعتبار المأمور به من قوله تعالى: (فاعتبروا) وبهذا يتبين أن الحكم به حكم بما أنزل الله فيضعف به استدلالهم بقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله) وبه يتبين أنه من جملة ما تناوله قوله تعالى: (تبيانا لكل شئ) وقوله تعالى: (ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) وقد قيل المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، وبهذا يتبين أن العمل بالقياس
لا يكون تقدما بين يدي الله ورسوله بل هو ائتمار بأمر الله وأمر رسوله، وسلوك طريق قد علم رسول الله أمته بالوقوف به على أحكام الشرع، وهذا لانا إنما نثبت الحكم في الفروع بالعلة المؤثرة، والعلة ما صارت مؤثرة بآرائنا بل بجعل الله إياها مؤثرة، وإنما إعمال الرأي في تمييز الوصف المؤثر من سائر
أوصاف الاصل وإظهار التأثير فيه فلا يكون العمل فيه عملا بالرأي، إنما التقدم بين يدي الله ورسوله فيما ذهب إليه الخصم من القول بأن العمل بالقياس باطل، لانه لا يجد ذلك في كتاب الله نصا، وهو لا يجوز الاستنباط ليقف به على إشارة النص فيكون ذلك قولا بغير حجة، ثم يكون عاملا في الاحكام بلا دليل، وقد بينا أن هذا لا يصلح أن يكون حجة أصلية.
وأما قوله: (ولا تقف ما ليس لك به علم) فالمذكور هو علم منكر في موضع النفي والنكرة في موضع النفي تعم، فاستعمال الرأي يثبت نوع علم من طريق الظاهر وإن كان لا يثبت علم اليقين، وبالاتفاق علم اليقين ليس بشرط لوجوب العمل ولا لجوازه، فإن العمل بخبر الواحد واجب ولا يثبت به علم اليقين، والعمل بالرأي في الحرب جائز، وفي باب القبلة عند الاشتباه واجب، وفي المعالجة بالادوية جائز وإن كان شئ من ذلك لا يوجب علم اليقين، وهذا لان التكليف بحسب الوسع وليس في وسعنا تحصيل علم اليقين في حكم كل حادثة، والحرج مدفوع، ففي إثبات الحجر عن إعمال الرأي في الحوادث التي لا نص فيها من الحرج ما لا يخفى.
ثم لا إشكال أن ما يثبت من العلم بطريق القياس فوق ما يثبت باستصحاب الحال، لان استصحاب الحال إنما يكون دليلا عندهم لعدم الدليل المغير، وذلك مما لا يعلم يقينا، قد يجوز أن يكون الدليل المغير ثابتا وإن لم يبلغ المبتلى به، ولهذا لا تقبل البينة على النفي في باب الخصومات وتقبل على الاثبات باعتبار طريق لا يوجب علم اليقين، فإن الشهادة بالملك لظاهر اليد أو اليد مع التصرف تكون مقبولة وإن كانت لا توجب علم اليقين.
فأما قوله تعالى: (ولا تقولوا على الله إلا الحق) قلنا ما يظهر عند استعمال الرأي بالوصف المؤثر حق في حقنا وإن كنا لا نعلم أنه هو الحق عند الله تعالى، ألا ترى أن المتحري في باب القبلة يلزمه التوجه إلى الجهة التي يستقر عليها الرأي، ومعلوم أنه لا يلزمه مباشرة ما ليس بحق أصلا،
فعرفنا أنه حق عندنا وإن كنا لا نقطع القول بأنه الحق عند الله تعالى، فقد يصيب المجتهد ذلك باجتهاده وقد يخطئ، ثم التكليف بحسب الوسع وليس في وضعنا الوقوف على ما هو حق عند الله لا محالة، وإنما الذي في وسعنا طلبه بطريق الاعتبار الذي أمرنا به وبعد إصابة ذلك الطريق يلزمنا العمل به فكذلك في الاحكام، وما أشاروا إليه من الفرق بين ما هو محض حق الله تعالى وبين ما فيه حق العباد ليس بقوي، لان المطلوب هنا جهة القبلة لاداء ما هو محض حق الله تعالى والله تعالى موصوف بكمال القدرة، ومع ذلك أطلق لنا العمل بالرأي فيه، إما لتحقيق معنى الابتلاء، أو لانه ليس في وسعنا ما هو أقوى من ذلك بعد انقطاع الادلة الظاهرة، وهذا المعنى بعينه موجود في الاحكام، ثم الاحتمال الذي يبقى بعد استعمال الرأي بمنزلة الاحتمال في خبر الواحد، فإن قول صاحب الشرع موجب علم اليقين وإنما يثبت في حقنا العلم والعمل به إذا بلغنا ذلك، وفي البلوغ والاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم احتمال، فكذلك الحكم في المنصوص ثابت بالنص على وجه يوجب علم اليقين، وفيه معنى هو مؤثر في الحكم شرعا ولكن في بلوغ الآراء وإدراك ذلك المعنى نوع احتمال، فلا يمنع ذلك وجوب العمل به عند انعدام دليل هو أقوى منه، ولهذا شرطنا للعمل بالرأي أن تكون الحادثة لا نص فيها من كتاب ولا سنة، فتبين أن فيما قلنا مبالغة في المحافظة على النصوص بظواهرها ومعانيها، فإنه ما لم يقف على النصوص لا يعرف أن الحادثة لا نص فيها وما لم يقف على معاني النصوص لا يمكنه أن يرد الحادثة إلى ما يكون مثلها من النصوص، ثم مع ذلك فيه تعميم المعنى في الفروع وتعظيم ما هو حق الله تعالى، فإن اعتقاد الحقية في الحكم المنصوص ثابت بالنص، ومعنى شرح الصدر وطمأنينة
القلب ثابت بالوقوف على المعنى.
ولا معنى لاستدلالهم باختلاف أحكام النصوص، لانا إنما نجوز استعمال الرأي عند معرفة معاني النصوص وإنما يكون هذا فيما يكون معقول المعنى، فأما فيما لا يعقل المعنى فيه فنحن لا نجوز إعمال الرأي لتعدية الحكم إلى ما لا نص فيه، وسيأتيك بيان هذا في شرط القياس، ويتبين بهذا أن مراد رسول الله
صلى الله عليه وسلم بذم الرأي فيما رووا من الآثار الرأي الذي ينشأ عن متابعة هوى النفس، أو الرأي الذي يكون المقصود منه رد المنصوص نحو ما فعله إبليس، فأما الرأي الذي يكون المقصود به إظهار الحق من الوجه الذي قلنا لا يكون مذموما، ألا ترى أن الله تعالى أمر به في إظهار قيمة الصيد بقوله: (يحكم به ذوا عدل منكم) فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك أصحابه والصحابة عن آخرهم أجمعوا على استعماله من غير نكير من أحد منهم على من استعمله، فكيف يظن بهم الاتفاق على ما ذمه رسول الله أو جعله مدرجة الضلال، هذا شئ لا يظنه إلا ضال، والله أعلم.
فصل: في بيان ما لا بد للقياس من معرفته قال رضي الله عنه: وذلك معنى القياس لغة، فالصورة بلا معنى يكون فاسدا من الدعوى، ثم شرطه فإن وجود الشئ على وجه يكون معتبرا شرعا لا يكون إلا بوجود شرطه، ثم ركنه فقوام الشئ يكون بركنه، ثم حكمه فإن الشئ إنما يخرج من حد العبث والسفه إلى حد الحكمة بكونه مفيدا، وذلك إنما يكون بحكمه، ثم بالدفع بعد ذلك فإن تمام الالزام إنما يتبين بالعجز عن الدفع.
فأما الاول فهو معرفة القياس لغة، فنقول: للقياس تفسير هو المراد بصيغته، ومعنى هو المراد بدلالته، بمنزله فعل الضرب فإن له تفسيرا هو المعلوم بصورته
وهو إيقاع الخشبة على جسم، ومعنى هو المراد بدلالته وهو الايلام.
فأما تفسير صيغة القياس فهو التقدير، يقال: قس النعل بالنعل: أي قدره به، وقاس الطبيب الجرح إذا سبره بالمسبار ليعرف مقدار غوره، وبهذا يتبين أن معناه لغة في الاحكام: رد الشئ إلى نظيره ليكون مثلا له في الحكم الذي وقعت الحاجة إلى إثباته، ولهذا يسمى ما يجري بين المناظرين مقايسة، لان كل واحد منهما يسعى ليجعل جوابه في الحادثة مثلا لما اتفقا على كونه أصلا بينهما، يقال: قايسته مقايسة وقياسا، ويسمى ذلك نظرا أيضا إذ لا يصاب إلا بالنظر عن إنصاف، ويسمى ذلك اجتهادا مجازا أيضا لان ببذل المجهود يحصل هذا المقصود.
وأما المعنى الذي هو المراد بدلالته، وهو أنه مدرك من مدارك أحكام الشرع، ومفصل من مفاصله، وإنما يتبين هنا ببسط الكلام فنقول: إن الله تعالى ابتلانا باستعمال الرأي والاعتبار، وجعل ذلك موضوعا على مثال ما يكون بين العباد مما شرعه من الدعوى والبينات، فالنصوص شهود على حقوق الله تعالى وأحكامه بمنزلة الشهود في الدعاوى، ومعنى النصوص (شهادته، بمنزلة) شهادة الشاهد، ثم لا بد من صلاحية الشاهد بكونه حرا عاقلا بالغا، فكذلك لا بد من صلاحية النص لكونه شاهدا بكونه معقول المعنى، ولا بد من صلاحية الشهادة بوجود لفظها، فكذلك لا بد من صلاحية الوصف الذي هو بمنزلة الشهادة، وذلك بأن يكون ملائما للحكم أو مؤثرا فيه على ما نبين الاختلاف فيه، ولا بد مما هو قائم مقام الطالب فيه وهو القائس، ولا بد من مطلوب وهو الحكم الشرعي، فالمقصود تعدية الحكم إلى الفروع، ولا بد من مقضي عليه وهو عقد القلب ليترتب عليه العمل بالبدن إن كان يحاج نفسه، وإن كان يحاج غيره فلا بد
من خصم هو كالمقضي عليه من حيث إنه يلزمه الانقياد له، ولا بد من قاض فيه وهو القلب بمنزلة القاضي في الخصومات، ثم بعد اجتماع هذه المعاني يتمكن المشهود عليه من الدفع كما في الدعوى المشهود عليه يتمكن من الدفع بعد ظهور الحجة فإن تمام الالزام إنما يتبين بالعجز عن الدفع، وربما يخالفنا في بعض هذا الشافعي وغيره من العلماء أيضا.
فصل: في تعليل الاصول قال فريق من العلماء: الاصول غير معلولة في الاصل ما لم يقم الدليل على كونه معلولا في كل أصل.
وقال فريق آخر: هي معلولة إلا بدليل مانع، والاشبه بمذهب الشافعي رحمه الله أنها معلولة في الاصل إلا أنه لا بد لجواز التعليل في كل أصل من دليل مميز، والمذهب عند علمائنا أنه لا بد مع هذا من قيام دليل يدل على كونه معلولا في الحال، وإنما يتبين هذا في مسألة
الذهب والفضة، فإن استدلال من يستدل من أصحابنا على كون الحكم الثابت فيهما معلولا بأن الاصول في الاصل معلولة لا يكون صحيحا حتى يثبت بالدليل أن النص الذي فيهما معلول في الحال.
وحجة الفريق الاول أن الحكم في المنصوص قبل التعليل ثابت بصيغة النص وفي التعليل تغيير لذلك الحكم حتى يكون ثابتا بالوصف الذي هو المعنى في المنصوص، فيكون ذلك بمنزلة المجاز من الحقيقة، ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل، بل أولى، فالمجاز أحد نوعي اللسان والمعنى الذي يستنبط من المنصوص ليس من نوع اللسان في شئ، يوضحه أن المعاني تتعارض في المنصوص وباعتبار المعارضة لا يتعين وصف منها بل كل وصف يحتمل أن يكون هو المعنى الموجب للحكم فيه والمحتمل لا يكون حجة، ولا بد من ترجيح
بعض الاوصاف عند الاشتغال بالتعليل، والترجيح بعد المعارضة لا يكون إلا بالدليل، على أنا نفهم من خطاب الشرع ما نفهم من مخاطباتنا، ومن يقول لغيره أعتق عبدي، هذا لم يكن له أن يصير إلى التعليل في هذا الامر، فكذلك في مخاطبات الشرع لا يجوز المصير إلى التعليل حتى يقوم الدليل.
وحجة الفريق الثاني أن الدليل الذي دل على صحة القياس وجواز العمل به يكون دليلا على جواز التعليل في كل أصل، فإن ما هو طريق التعليل وهو الوقوف على معنى النص والوصف الذي هو صالح لان يكون علة للحكم موجود في كل نص، فيكون جواز التعليل أصلا في كل نص، وتكون صفة الصلاحية أصلا في كل وصف، فيكون التعليل به أصلا ما لم يظهر المانع، بمنزلة العمل بالاخبار، فإن وجوب العمل بكل خبر ثبت عن صاحب الشرع هو الاصل حتى يمنع منه مانع، ولا تتحقق المعارضة الموجبة للتوقف بمجرد اختلاف الآثار عند إمكان العمل بالكل، فكذلك لا تثبت المعارضة الموجبة للتوقف عند كثرة أوصاف الاصل مع إمكان العمل بالكل إلا أن يمنع من ذلك مانع، وليس هذا نظير خطاب العباد في معاملاتهم، فإن ذلك مما لا نشتغل فيه
بطلب المعنى، لجواز أن يكون خاليا عن معنى مؤثر وعن حكمة حميدة بخلاف خطاب الشرع، ألا ترى أن هناك وإن كان التعليل فيه منصوصا لا يصار إلى التعدية، فإنه لو قال أعتق عبدي هذا فإنه أسود لم يكن له أن يعدي الحكم بهذا التعليل إلى غيره، وفي خطاب الشرع فيما يكون التعليل منصوصا يثبت حكم التعدية بالاتفاق، كقوله عليه السلام: الهرة ليست بنجسة لانها من الطوافين عليكم والطوافات ودعواهم أن في التعليل تغيير الحكم كلام باطل، فإن الحكم في المنصوص بعد التعليل ثابت بالنص كما كان قبل التعليل، وإنما
التعليل لتعدية الحكم إلى محل آخر لا نص فيه على ما نبينه في فصل الشرط، فعرفنا أن أثر التعليل في المنصوص من حيث شرح الصدر وطمأنينة القلب، وذلك تقرير للحكم لا تغيير كالوقوف على معنى اللسان.
وقولهم إن في كل وصف احتمالا، قلنا: لا كذلك بل الاصل في النصوص وجوب التعليل لتعميم الحكم على ما قررنا، فبعد هذا في كل وصف احتمال أنه ليس بمراد بعد قيام الدليل على كونه حجة (وما ثبت حجة بالدليل فإنه لا يخرج بالاحتمال من أن يكون حجة) وإنما يثبت ذلك بالدليل المانع.
وأما الشافعي فإنه يقول: قد علمنا بالدليل أن علة النص أحد أوصافه لا كل وصف منه، فإن الصحابة اختلفوا في الفروع باختلافهم في الوصف الذي هو علة في النص، فكل واحد منهم ادعى أن العلة ما قاله، وذلك اتفاق منهم أن أحد الاوصاف هو العلة، ثم ذلك الوصف مجهول والمجهول لا يصلح استعماله مع الجهالة لتعدية الحكم فلا بد من دليل التمييز بينه وبين سائر الاوصاف حتى يجوز التعليل به، فإنه لا يجوز التعليل بسائر الاوصاف لاتفاق الصحابة على ذلك وعلمنا ببطلان التعليل في مخالفة الاجماع.
ثم على أصله التعليل تارة يكون للمنع من التعدية، وتارة يكون لاثبات التعدية، ولا شك أن الوصف الذي به يثبت الحجر عن التعدية غير الوصف الذي يثبت به حكم التعدية، فما لم يتميز أحد الوصفين من الآخر بالدليل لا يجوز تعليل النص.
وأما علماؤنا فقد شرطوا الدليل المميز، ولكن بطريق آخر سوى ما ذكره الشافعي على ما نذكره في بابه (إن شاء الله) وشرطوا قبل ذلك أن يقوم الدليل في الاصل على كونه معلولا في الحال، لان النصوص نوعان: معلول، وغير معلول، والمصير إلى التعليل في كل نص، بعد زوال
هذا الاحتمال، وذلك لا يكون إلا بدليل يقوم في النص على كونه معلولا في الحال.
وإنما نظيره مجهول الحال إذا شهد، فإنه ما لم نثبت حريته بقيام الدليل عليه لا تكون شهادته حجة في الالزام، وقبل ثبوت ذلك بالدليل الحرية ثابتة بطريق الظاهر، ولكن هذا يصلح للدفع لا للالزام، فكذلك الدليل الذي دل في كل نص على أنه معلول ثابت من طريق الظاهر وفيه احتمال، فما لم يثبت بالدليل الموجب لكون هذا النص معلولا لا يجوز المصير إلى تعليله لتعدية الحكم إلى الفروع، ففيه معنى الالزام، وهو نظير استصحاب الحال، فإنه يصلح حجة للدفع لا للالزام لبقاء الاحتمال فيه.
فإن قيل: أليس أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله جائز ما لم يقم الدليل المانع، وقد ظهرت خصوصيته في بعض الافعال، ثم لم يوجب ذلك الاحتمال في كل فعل حتى يقال لا يجوز الاقتداء به إلا بعد قيام الدليل ؟ قلنا: رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام مقتدى به، ما بعث إلا ليأخذ الناس بهديه وهداه، فيكون الاقتداء به هو الاصل وإن كان قد يجوز أن يكون هو مخصوصا ببعض الاشياء، ولكن الخصوصية في حقه بمنزلة دليل التخصيص في العموم والعمل بالعام مستقيم حتى يقوم دليل التخصيص، فكذلك الاقتداء به في أفعاله.
فأما هنا فاحتمال كون النص غير معلول ثابت في كل أصل مثل احتمال كونه معلولا، فيكون هذا بمنزلة المجمل فيما يرجع إلى الاحتمال، والعمل بالمجمل لا يكون إلا بعد قيام دليل هو بيان، فكذلك تعليل الاصول، يوضحه أن هناك
قد قام الدليل الموجب لعلم اليقين على جواز الاقتداء به مطلقا، وهو قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وههنا الدليل هو صلاحية الوصف الموجود في النص، وذلك إنما يعلم بالرأي فلا ينعدم به احتمال كون النص غير
معلول، لانا قد بينا أن في تعليل النص معنى الابتلاء، والابتلاء بما يكون غير معلول من النصوص أظهر، وبعدما تحققت المساواة في معنى الابتلاء لا بد من قيام الدليل في المنصوص على أنه معلول للحال.
وبيان هذا في الذهب والفضة، فإن حكم الربا ثابت فيهما بالنص وهو معلول عندنا بعلة الوزن.
وأنكر الشافعي هذا فيحتاج إلى أن يثبت بالدليل أنه معلول.
وفيه نوعان من الدليل: أحدها قوله عليه السلام: يد بيد ففيه إيجاب التعيين وهو متعد إلى الفروع لانه لا بد من تعيين أحد البدلين في كل عقد، فإن الدين بالدين حرام بالنص وذلك ربا، كما قال عليه السلام: إنما الربا في النسيئة ثم وجوب التعيين في البدل الآخر هنا لاشتراط المساواة، فالمساواة في البدلين عند اتفاق الجنس شرط بقوله عليه السلام: مثل بمثل وعند اختلاف الجنس المساواة في العينية شرط بقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد وهذا حكم متعد إلى الفروع، فإن الشافعي يشترط التقايض في بيع الطعام بالطعام مع اختلاف الجنس بهذا النص، ونحن لا نجوز بيع قفيز من حنطة بعينها بقفيز من شعير بغير عينه غير مقبوض في المجلس وإن كان موصوفا وحل التفاضل بينهما، لان بترك التعيين في المجلس ينعدم المساواة في اليد باليد، وشرطنا القبض في رأس مال السلم في المجلس لتحقيق معنى التعيين، فعرفنا أنه معلول، والتعليل بالثمنية يمنع التعدية، فباعتبار كونه معلولا يكون متعديا إلى الفروع، فالوصف الذي يمنع التعدية لا يقدح فيه ولا يخرجه من أن يكون شاهدا، بمنزلة صفة الجهل في الشاهد فإنه لا يكون طعنا في شهادته لانه لا يخرج به من أن يكون أهلا للولاية، والشهادة تبتنى على ذلك، بخلاف صفة الرق فإن الطعن به يمنع العمل بشهادته حتى تثبت حريته بالحجة، لانه يخرج به من أن يكون أهل الولاية والصلاحية للشهادة تبتنى على
ذلك.
ومثال هذا أيضا ما قاله الشافعي في تحريم الخمر إنه معلول من غير قيام الدليل فيه على كونه معلولا، بل الدليل من النص دال على أنه غير معلول، وهو قوله عليه السلام: حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب وإثبات الحرمة وصفة النجاسة في بعض الاشربة المسكرة لا يكون تعدية للحكم الثابت في الخمر، ألا ترى أنه لا يثبت على ذلك الوجه حتى لا يكفر مستحله، ولا يكون التقدير في النجاسة فيه كالتقدير في الخمر، وإنما تلك حرمة ثابتة باعتبار نوع من الاحتياط، فلا يتبين به كون النص معلولا.
ثم تعليل النص قد يكون تارة بالنص، نحو قوله تعالى: (كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم) وقول النبي عليه السلام لبريرة: ملكت بضعك فاختاري وقد يكون بفحوى النص كقول النبي عليه السلام في السمن الذي وقعت فيه فأرة: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا ما بقي، وإن مائعا فأريقوه فإن في هذا إشارة إلى أنه معلول بعلة مجاورة النجاسة إياه.
وكذلك خبر الربا من هذا النوع كما بينا، وقد يكون بالاستدلال بحكم النص كقوله عليه السلام في دم الاستحاضة: إنه دم عرق انفجر فتوضئي لكل صلاة.
وقد يكون على اتفاق القائلين بالقياس على كونه معلولا، فعند وجود شئ من هذه الادلة في النص سقط اعتبار احتمال كونه غير معلول.
فصل: في ذكر شرط القياس وإنما قدمنا الشرط لان الشرعيات لا تصير موجودة بركنها قبل وجود الشرط، ألا ترى أن من أراد النكاح فلا بد له من أن يبدأ بإحضار الشهود، ومن أراد الصلاة لم يجد بدا من البداية بالطهارة وستر العورة.
وهذه الشروط خمسة: أحدها أن لا يكون حكم الاصل مخصوصا به بنص
آخر، والثاني أن لا يكون معدولا به عن القياس، والثالث أن لا يكون التعليل للحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه حتى يتعدى به إلى فرع هو نظيره ولا نص
فيه، والرابع أن يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان قبله، والخامس أن لا يكون التعليل متضمنا إبطال شئ من ألفاظ المنصوص.
أما الاول: فلان التعليل لتعدية الحكم، وذلك يبطل التخصيص الثابت بالنص، فكان هذا تعليلا في معارضة النص لدفع حكمه والقياس في معارضة النص باطل.
وأما الثاني: فلان التعليل يكون مقايسة والحكم المعدول به عن القياس الثابت بالنص لا مدخل للقياس فيه على موافقة النص، ولا معتبر بالقياس فيه على مخالفة النص، لان المقصود بالتعليل إثبات الحكم به في الفرع والقياس ينفي هذا الحكم، ولا يتحقق الاثبات بحجة النفي كما لا يتحقق التحليل بما هو حجة التحريم.
وأما الثالث: فلان المقايسة إنما تكون بين شيئين ليعلم به أنهما مثلان فلا تصور له في شئ واحد ولا في شيئين مختلفين لا تتحقق المماثلة بينهما، فإذا لم يتعد الحكم بالتعليل عن المنصوص عليه يكون شيئا واحدا لا تتحقق فيه المقايسة، وإذا كانا مختلفين لا يصيران بالتعليل مثلين، ومحل الانفعال شرط كل فعل وقول كمحل هو حي فإنه شرط ليكون صدمه ضربا وقطعه قتلا، واشتراط كونه حكما شرعيا، لان الكلام في القياس على الاصول الثابتة شرعا، وبمثل هذا القياس لا يعرف إلا حكم الشرع، فإن الطب واللغة لا يعرف بمثل هذا القياس.
وأما الرابع: فلان العمل بالقياس يكون بعد النص، وفي الحكم الثابت بالنص
لا مدخل للقياس في التغيير كما لا مدخل له في الابطال، فإذا لم يبق حكم النص بعد التعليل في المنصوص على ما كان قبله كان هذا بيانا مغيرا لحكم النص أو مبطلا له، ولا معتبر بالقياس في معارضة النص.
وأما الخامس: فلان النص مقدم على القياس بلفظه ومعناه، فكما لا يعتبر
القياس في معارضة النص بإبطال حكمه لا يعتبر في ممارسته بإبطال لفظه.
وفي بعض هذه الفصول يخالفنا الشافعي رحمه الله على ما نبينه.
فأما المثال الاول وهو أن العدد معتبر في الشهادات المطلقة بالنص، وقد فسر الله تعالى الشاهدين برجلين أو رجل وامرأتين وذلك تنصيص على أدنى ما يكون من الحجة لاثبات الحق، ثم خص رسول الله صلى الله عليه وسلم خزيمة رضي الله عنه بقبول شهادته وحده، فكان ذلك حكما ثبت بالنص اختصاصه به كرامة له، فلم يجز تعليله أصلا حتى لا يثبت ذلك الحكم في شهادة غير خزيمة ممن هو مثله أو دونه أو فوقه في الفضيلة لان التعليل يبطل خصوصيته.
وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بأن حل له تسع نسوة فقد ثبت بالنص أن الحل بالنكاح يقتصر على الاربعة ثم ظهرت خصوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام بالزيادة بنص آخر فلم يكن ذلك قابلا للتعليل.
وكذلك ظهرت خصوصيته بالنكاح (بغير مهر بالنص فلم يكن ذلك قابلا للتعليل.
وقال الشافعي: قد ظهرت خصوصيته بالنكاح) بلفظ الهبة بالنص وهو قوله تعالى: (خالصة لك من دون المؤمنين) فلم يجز التعليل فيه لتعدية الحكم إلى نكاح غيره.
ولكنا نقول: المراد بالنص الموجب للتخصيص ملك البضع نكاحا بغير مهر، فإنه ذكر فعل الهبة وذلك يقتضي مصدرا، ثم قوله تعالى: (خالصة لك) نعت ذلك المصدر: أي إن وهبت
نفسها للنبي هبة خالصة، بدليل قوله تعالى: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) : أي من الابتغاء بالمال المقدر، فالفرض عبارة عن التقدير وذلك في المال يكون لا في لفظ النكاح والتزويج، أو المراد اختصاصه بالمرأة حتى لا تحل لاحد بعده فيتأدى هو بكون الغير شريكا له في فراشها من حيث الزمان، وعليه دل قوله تعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) ألا ترى أن معنى الكرامة بالاختصاص إنما تظهر فيما يتوهم فيه الحرج بإلزامه إياه وذلك
لا يتحقق في اللفظ، فقد كان أفصح العرب لا يلحقه الحرج في لفظ النكاح والتزويج.
ومن هذه الجملة اشتراط الاجل في السلم، فإنه حكم ثابت بالنص في هذا العقد خاصا، وهو قوله عليه السلام: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
فلا يجوز المصير فيه إلى التعليل حتى يجوز السلم حالا بالقياس على البيع بعلة أنه نوع بيع، لان الاصل في جواز البيع اشتراط قيام المعقود عليه في تلك العاقد والقدرة على التسليم، حتى لو باع ما لا يملكه ثم اشتراه فسلمه لا يجوز، ثم ترك هذا الاصل في السلم رخصة بالنص وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم وهذا لان المسلم فيه غير مقدور التسليم للعاقد عند العقد، ولا يصير مقدور التسليم له بنفس العقد، لان العقد سبب للوجوب عليه وقدرته على التسليم يكون بما له لا بما عليه، ولكنه محتاج إلى مباشرة هذا العقد لتحصيل البدل مع عجزه عن تسليم المعقود عليه في الحال، وقدرته على ذلك بعد مضي مدة معلومة بطريق العادة
إما بأن يكتسب أو يدرك غلاته بمجئ أوانه، فجوز الشرع هذا العقد مع عدم المعقود عليه في ملكه رخصة لحاجته، ولكن بطريق يقدر على التسليم عند وجوب التسليم عادة وذلك بأن يكون مؤجلا، فلم يجز التعليل فيه لكونه حكما خاصا ثبت الخصوصية فيه بالنص كما بينا.
وكذلك قلنا: المنافع لا تضمن بالاتلاف والغصب، لان وجوب الضمان يستدعي المالية والتقوم في المتلف وذلك لا يسبق الاحراز ولا تصور للاحراز في المنافع، ثم ثبوت المالية والتقوم فيها بالعقد حكم خاص ثبت بالنص، فلم يكن قابلا للتعليل.
وكذلك إثبات المعادلة بينهما وبين الاعيان في موجب العقد الفاسد، والصحيح حكم خاص فيها، لانه لا مماثلة بين المنافع وبين الاعيان باعتبار الاصل، فالعين جوهر يقوم به العرض، والمنفعة عرض يقوم بالجوهر،
والمنافع لا تبقى وقتين والعين تبقى، وبين ما يبقى وبين ما لا يبقى تفاوت، فعرفنا أن ثبوت المساواة بينهما في مقتضى العقد حكم خاص ثابت بالنص فلا يقبل التعليل.
وكذلك إلزام العقد على المنافع قبل وجودها حكم خاص ثبت للحاجة أو للضرورة، من حيث إنه لا يتصور العقد عليها بعد الوجود، لان الموجود لا يبقى إلى وقت التسليم، وما لا يتأتى فيه التسليم بحكم العقد لا يكون محلا للعقد، فلا يجوز تعدية هذا الحكم بالتعليل إلى المحل الذي يتصور العقد عليه بعد الوجود، وهو نظير حل الميتة عند المخمصة، فإن ثبوته لما كان بطريق الضرورة لم يجز تعليله لتعدية ذلك الحكم إلى محل آخر.
ومثال الفصل الثاني ما قال أبو حنيفة رحمه الله في جواز التوضي بنبيذ التمر، فإنه حكم معدول به عن القياس بالنص فلم يكن قابلا للتعليل حتى لا يتعدى ذلك الحكم (إلى سائر الانبذة، ووجوب الطهارة بالقهقهة في الصلاة
حكم معدول به عن القياس بالنص فلم يكن قابلا للتعليل حتى لا يتعدى الحكم) إلى صلاة الجنازة وسجدة التلاوة، لان النص ورد في صلاة مطلقة وهي ما تشتمل على جميع أركان الصلاة.
وكذلك بقاء الصوم مع الاكل والشرب ناسيا، فإنه معدول به عن القياس بالنص، لان ركن الصوم ينعدم بالاكل مع النسيان، والركن هو الكف عن اقتضاء الشهوات، وأداء العبادة بعد فوات ركنها لا يتحقق، فعرفنا أنه عن معدول به عن القياس فلم يجز تعدية الحكم فيه إلى المخطئ والمكره والنائم يصب في حلقه بطريق التعليل.
فإن قيل: قد عديتم حكم النص إلى الجماع، وقد ورد في الاكل والشرب وكان ذلك بطريق التعليل.
قلنا: لا كذلك بل قد ثبت بالنص المساواة بين الاكل والشرب والجماع في حكم الصوم، وإن ركن الصوم هو الكف عن اقتضاء الشهوتين جميعا فيكون الحكم الثابت (بالنص)
في أحدهما ثابتا في الآخر بالنص أيضا لا بالمقايسة، لانه ليس بينهما فرق في حكم الصوم الشرعي سوى اختلاف الاسم، فإن الاقدام على كل واحد منهما فيه تفويت ركن الصوم، لانه جناية على محل الفعل من بضع أو طعام، وهو نظير جزء الرقبة مع شق البطن فإنهما فعلان مختلفان في الاسم، وكل واحد منهما قتل موجب للقود بالنص لا بالقياس.
وكذلك من به سلس البول يتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة، وكان الحكم في كل واحد منهما ثابتا بالنص لا بالقياس، لان النص ورد عند استدامة العذر.
وعلى هذا قلنا: من سبقه الحدث في خلال الصلاة بأي وجه سبقه فإنه يتوضأ ويبني على صلاته بالنص، وذلك حكم معدول به عن القياس، وإنما ورد النص في القئ
والرعاف، ثم جعل ذلك ورودا في سائر الاحداث الموجبة للوضوء ولم يجعل ورودا في الحدث الموجب للاغتسال لتحقق المغايرة فيما بينهما.
فإن قيل: فكذلك نقول في المكره والخاطئ، فالمساواة بينهما وبين الناسي ثابت من حيث إن كل واحد منهما غير قاصد إلى الجناية على الصوم.
قلنا: نعم ولكن هذا إنما يستقيم إذا ثبت أن القصد معتبر في تفويت ركن الصوم، وإذا كان القصد لا يعتبر في تحقق ركن الصوم حتى إن من كان مغمى عليه في جميع النهار يتأدى ركن الصوم منه، فكذلك ترك القصد لا يمنع تحقق فوات ركن الصوم، وكذلك مع عدم القصد قد يتحقق فوات ركن الصوم وانعدام الاداء به، فإن من أغمى قبل غروب الشمس وبقي كذلك إلى آخر الغد فإنه لا يكون صائما، وإن انعدم منه القصد إلى ترك الصوم، ثم لا مساواة أيضا بين الخاطئ والمكره وبين الناسي فيما يرجع إلى عدم القصد، فإن الخاطئ إنما انعدام القصد منه باعتبار قصده إلى المضمضة، وإنما ابتلي بالشرب خطأ بطريق يمكن التحرز عنه.
وأما الناسي فانعدم القصد منه لعدم علمه بالصوم أصلا وذلك بنسيان لا صنع له فيه، وإليه أشار عليه السلام في قوله: إن الله أطعمك وسقاك ولما كان سبب العذر ممن له الحق على وجه لا صنع للعباد فيه استقام أن يجعل الركن باعتباره
قائما حكما، فأما في المكره والنائم سبب العذر جاء من جهة العباد، والحق في أداء الصوم لله فلم يكن هذا في (معنى) سبب كان ممن له الحق، ألا ترى أن المريض يصلي قاعدا ثم لا تلزمه الاعادة إذا برأ، والمقيد يصلي قاعدا ثم تلزمه الاعادة إذا رفع القيد عنه.
وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: الذي شج في صلاته لا يبني بعد الوضوء، والذي ابتلي بقئ
أو رعاف يبني على صلاته بعد الوضوء، لما أن ذلك حكم معدول به عن القياس بالنص فلم يجز التعليل فيه، وما يبتنى على صنع العباد ليس نظير ما لا صنع للعباد من كل وجه.
ومن هذه الجملة قلنا: حل الذبيحة مع ترك التسمية ناسيا حكم معدول به عن القياس بالنص، فلم يجز تعليله لتعدية الحكم إلى العامد ولا مساواة بينهما، فالناسي معذور غير معرض عن ذكر اسم الله تعالى، والعامد جان معرض عن ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة.
ومن أصحابنا من ظن أن المستحسنات كلها بهذه الصفة وليس كما ظن، فالمستحسن قد يكون معدولا به عن القياس، وقد يكون ثابتا بنوع من القياس إلا أنه قياس خفي على ما نبينه في بابه إن شاء الله تعالى.
ومن أصحابنا من ظن أن في الحكم الذي يكون ثابتا بالنص فيه معنى معقول، إلا أنه يعارض ذلك المعنى معان أخر تخالفه، فالجواب فيه كذلك، إلا أنه لا يجوز التعليل فيه وليس كذلك، فإن الاصل بمنزلة الراوي والوصف الذي به تعلل بمنزلة الحديث، وفي رواية الاخبار قد يقع الترجيح باعتبار كثرة الرواة على ما بينا، ولكن به لا يخرج من أن تكون رواية الواحد معتبرا، فعرفنا أنه متى كان النص معقول المعنى فإنه يجوز تعليله بذلك المعنى ليتعدى الحكم به إلى فرع، وإن عارض ذلك المعنى معان أخر في الاصل، فإنه ليس من شرط التعليل للتعدية اعتبار جميع معاني الاصل.
وأما الفصل الثالث: فهو أعظم هذه الوجوه فقها، وأعمها نفعا، وهو شرط واحد اسما ولكن يدخل تحته أصول.
فمنها: أن الكلام متى كان من معنى اللغة فإنه لا يجوز المصير فيه إلى
الاثبات بالقياس الشرعي.
وبيان هذا في اليمين الغموس، فإن علماءنا قالوا إنها لا تنعقد موجبة للكفارة، لانها ليست بيمين معقودة ووجوب الكفارة بالنص في اليمين المعقودة، وكان الاشتغال في الحكم بالتعليل بقوله يمين بالله مقصودة باطلا من الكلام، لان الكلام في إثبات الاسم حقيقة، فعندنا هذه ليست بيمين حقيقة، وإنما سميت يمينا مجازا، لان ارتكاب هذه الكبيرة كان باستعمال صورة اليمين كبيع الحر يسمى بيعا مجازا وإن لم يكن بيعا على الحقيقة، وإذا كان الكلام في إثبات اسم اليمين حقيقة وذلك لا يمكن معرفته بالقياس الشرعي كان الاشتغال به فضلا من الكلام، ولكن طريق معرفته التأمل في أصول أهل اللغة، وهم إنما وضعوا اليمين لتحقيق معنى الصدق من الخبر، فعرفنا أن ما ليس فيه توهم الصدق بوجه لا يكون محلا لليمين لخلوه عن فائدة، وبدون المحل لا يتصور انعقاد اليمين، ولذلك قال أبو حنيفة في اللواطة إنها لا توجب الحد، لانها ليست بزنا واشتغال الخصوم بتعليل نص الزنا لتعدية الحكم أو إثبات المساواة بينه وبين اللواطة يكون فاسدا، لان طريق معرفة الاسم النظر في موضوعات أهل اللغة لا الاقيسة الشرعية.
وكذلك سائر الاشربة سوى الخمر لا يجب الحد بشرب القليل ما لم يسكر، واشتغال الخصم بتعليل نص الخمر لتعدية الحكم أو لاثبات المساواة فاسد، لان الكلام في إثبات هذا الاسم كسائر الاشربة.
فإن قيل: اعتبار المعنى لاثبات المساواة في الاسم لغة لا شرعا، فالزنا عند أهل اللغة اسم لفعل فيه اقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء دون النسل، ولهذا سموه سفاحا وسموا النكاح إحصانا، واللواطة مثل الزنا في هذا المعنى من كل وجه.
وكذلك الخمر اسم لعين تحصل مخامرة العقل
بشربه ولهذا لا يسمى العصير به قبل التخمر ولا بعد التخلل، وهذه الاشربة مساوية للخمر في هذا المعنى.
قلنا هذا فاسد، لان الاسماء الموضوعة للاعيان أو للاشخاص عند أهل اللغة المقصود بها تعريف المسمى وإحضاره بذلك الاسم لا تحقق ذلك الوصف في المسمى، بمنزلة الاسماء الموضوعة للرجال والنساء كزيد وعمر وبكر وما أشبهه، فكذلك أسماء الافعال كالزنا واللواطة وأسماء الاعيان كالخمر، وما هذه الدعوى إلا نظير ما يحكى عن بعض الموسوسين أنه كان يقول: أنا أبين المعنى في كل اسم لغة أنه لماذا وضع ذلك الاسم لغة لما يسمى به.
فقيل له: لماذا يسمى الجرجير جرجيرا ؟ فقال: لانه يتجرجر إذا ظهر على وجه الارض، أي يتحرك.
فقيل له: فلحيتك تتحرك أيضا ولا تسمى جرجيرا ! فقيل له: لماذا سميت القارورة قارورة ؟ قال: لانه يستقر فيها المائع.
فقيل له: فجوفك أيضا يستقر فيه المائع ولا يسمى قارورة !.
ولا شك أن الاشتغال بمثل هذا في الاسماء الموضوعة يكون من نوع الجنون.
فإن قيل: الاحكام الشرعية إنما تبتنى على الاسامي الثابتة شرعا وذلك نوع من الاسامي لا يعرفه أهل اللغة كاسم الصلاة للاركان المعلومة، واسم المنافق لبعض الاشخاص.
وما أشبه ذلك.
قلنا: الاسماء الثابتة شرعا تكون ثابتة بطريق معلوم شرعا كالاسماء الموضوعة لغة تكون ثابتة بطريق يعرفه أهل اللغة، ثم ذلك الاسم لا يختص بعلمه واحد من أهل اللغة، بل يشترك فيه جميع أهل اللغة لاشتراكهم في طريق معرفته، فكذلك هذا الاسم يشترك في معرفته جميع من يعرف أحكام الشرع، وما يكون بطريق الاستنباط والرأي فإنما يعرفه القايس، فبهذا يتبين أنه لا يجوز
إثبات الاسم بالقياس على أي وجه كان، وعلى هذا لا يجوز استعمال القياس في إلحاق النباش بالسارق في حكم القطع، لان القطع بالنص واجب على السارق، فالكلام في إثبات اسم السرقة حقيقة وقد قدمنا البيان في نفي التسوية
بين النباش والسارق في فعل السرقة، وهذا لان الاسماء نوعان: حقيقة، ومجاز.
فطريق معرفة الحقيقة هو السماع من أهل اللغة، وطريق معرفة المجاز منه الوقوف على استعارة أهل اللغة، ونحن نعلم أن طريق الاستعارة فيما بين أهل اللغة غير طريق التعدية في أحكام الشرع، فلا يمكن معرفة هذا النوع بالتعليل الذي هو لتعدية حكم الشرع.
وعلى هذا قلنا: الاشتغال بالقياس لتصحيح استعارة ألفاظ الطلاق للعتق يكون باطلا، وإنما نشتغل فيه بالتأمل فيما هو طريق الاستعارة عند أهل اللغة.
وكذلك الاشتغال بالقياس لاثبات الاستعارة في ألفاظ التمليك للنكاح يكون اشتغالا بما لا معنى له.
وكذلك في إثبات استعارة لفظ النسب للعتق.
وكذلك الاشتغال بالقياس في تصحيح إرادة العدد من لفظ الطلاق.
والاشتغال بالقياس لاثبات الموافقة بين الشاهدين إذا شهد أحدهما بمائة والآخر بمائتين أو شهد أحدهما بتطليقة والآخر بنصف تطليقة فإنما يكون من نوع هذا (فالحاجة فيه إلى إثبات الاسم وطريق الوقوف عليه التأمل في طريقه عند أهل اللغة) فكان الاشتغال بالقياس الشرعي فيه اشتغالا بما لا يفيد.
وكذلك الاطعام في الكفارات فإن اشتراط التمليك فيه بالقياس على الكسوة باطل، لان الكلام في معنى الاطعام المنصوص عليه ولا مدخل للقياس الشرعي في معرفة معنى الاسم لغة، وإنما الطريق فيه التأمل في معنى اللفظ لغة وهو فعل متعد فلازمه طعم وحقيقته فيما يصير المسكين به طاعما، وذلك بالتمكين من الاطعام، بمنزلة الايكال، ثم يجوز التمليك فيه بدلالة النص، فأما الكسوة
فهو عبارة عن الملبوس دون فعل اللبس ودون منفعة الثوب وعين الملبوس لا يصير كفارة إلا بالتمليك من المسكين، فأما الالباس فهو تمكين من الانتفاع بالملبوس.
ومن هذه الجملة: الاختلاف في شرط التعدية، والمذهب عندنا أن تعليل النص بما لا يتعدى لا يجوز أصلا.
وعند الشافعي هذا التعليل جائز ولكنه لا يكون مقايسة، وعلى هذا جوز هو تعليل نص الربا في الذهب والفضة
بالثمينة وإن كانت لا تتعدى، فنحن لا نجوز ذلك.
والمذهب عندنا أن حكم التعليل هو تعدية حكم الاصل إلى الفروع، وكل تعليل لا يفيد ذلك فهو خال عن حكمه، وعلى قوله حكم التعليل ثبوت الحكم في المنصوص بالعلة ثم تتعدى تلك العلة إلى الفروع تارة فيثبت بها الحكم في الفروع كما في الاصل، وتارة لا تتعدى فيبقى الحكم في الاصل ثابتا وبه يكون ذلك تعليلا مستقيما بمنزلة النص الذي هو عام مع النص الذي هو خاص.
احتج وقال لان التعليل بالرأي حجة لاثبات حكم الشرع فيكون بمنزلة سائر أنواع الحجج، وسائر الحجج من الكتاب والسنة أينما وجدت يثبت الحكم بها، فكذلك التعليل بالرأي إلا أن سائر الحجج تكون ثابت بغير صنع منا، والتعليل بالرأي إنما يحصل بصنعنا، ومتى وجد ذلك كان ثبوت الحكم مضافا إليه سواء تعدى إلى الفروع أو لم يتعد، وهذا لان الشرط في الوصف الذي يتعلل الاصل به قيام دلالة التمييز بينه وبين سائر الاوصاف، وهذا المعنى يتحقق في الوصف الذي يقتصر على موضع النص وفي الوصف الذي يتعدى إلى محل آخر، وبعد ما وجد فيه شرط صحة التعليل به لا يثبت الحجر عن التعليل به إلا بمانع، فكونه غير متعد لا يصلح أن يكون مانعا
إنما المانع ما يخرجه من أن يكون حجة، وانعدام وصف التعدي فيه لا يخرجه من أن يكون حجة كالنص.
والجواب عن هذا الكلام بما هو الحجة لنا، وهو أن الحجج الشرعية لا بد أن تكون موجبة علما أو عملا، والتعليل بالرأي لا يوجب العلم بالاتفاق، فعرفنا أنه موجب للعمل وأنه باعتباره يصير حجة، والموجب للعمل ما يكون متعديا إلى الفروع، لان وجوب العمل بالعلة إنما يظهر في الفرع، فأما الاصل فقد كان موجبا للعمل في المحل الذي تناوله قبل التعليل، فإذا خلا عن التعليل لم يكن موجبا شيئا فلا يكون حجة شرعا.
فإن قيل: وجوب العمل في الاصل بعد أن التعليل يصير مضافا إلى العلة كما أن في الفرع بعد التعدية يصير وجوب العمل مضافا إلى العلة.
قلنا: هذا فاسد، لان قبل التعليل كان وجوب العمل بالنص، والتعليل لا يجوز على وجه يكون مغيرا حكم الاصل، فكيف يجوز على وجه يكون مبطلا حكم الاصل وهو إضافة وجوب العمل إليه، ألا ترى أن وجوب العمل به لما كان مضافا إلى النص قبل التعليل بقي مضافا إليه بعد التعليل، وبه يتبين أن النص أقوى والضعيف لا يظهر في مقابلة القوي، فيكون الحكم وهو وجوب العمل في الاصل مضافا إلى أقوى الحجتين وهو النص بعد التعليل كما كان قبله.
واعتباره الاصل بالفرع في أن الحكم فيه يكون مضافا إلى العلة في نهاية الفساد، لان الفرع يعتبر الاصل، فأما الاصل لا يعتبر بالفرع في معرفة حكمه بحال.
فإن قيل مع هذا: التعليل صحيح ليثبت به تخصيص الاصل بذلك الحكم.
قلنا: وهذا ثابت قبل التعليل بالنص، ثم تعليل الاصل بوصف لا يتعدى
لا يمنع تعليله بوصف آخر يتعدى إذا وجد فيه ما هو شرط العلة، لانه كما يجوز أن يجتمع في الاصل وصفان كل واحد منهما يتعدى إلى فروع وأحدهما أكثر تعدية من الآخر يجوز أن يجتمع وصفان يتعدى أحدهما ولا يتعدى الآخر، فبهذا تبين أن هذا التعليل لا يوجب تخصيص الاصل أيضا.
وكيف يقال هذا وبالاجماع بيننا وبينه انعدام العلة لا يوجب انعدام الحكم على ما نبينه في بابه إن شاء الله تعالى، وإنما يكون التعليل بما لا يتعدى موجبا تخصيص الاصل إذا كان الحكم ينعدم بانعدام العلة كما يوجد بوجودها.
ومن هذه الجملة: تعليل الاصل لتعدية الحكم إلى موضع منصوص، فإن ذلك لا يجوز عندنا، نص عليه محمد السير الكبير، وقال: النص الوارد في هدي المتعة لا يجوز تعليله لتعدية حكم الصوم فيه إلى هدي الاحصار، لان ذلك منصوص عليه وإنما يقاس بالرأي على المنصوص ولا يقاس المنصوص
على المنصوص.
والشافعي يجوز هذا التعليل لاثبات زيادة في حكم النص الآخر بالتعليل، ولهذا قال: يجوز تعليله على وجه يوجب زيادة في حكم النص الآخر لا على وجه يوجب ما هو خلاف حكم النص الآخر، لان وجوب الزيادة به إذا كان النص الآخر ساكتا عنه يكون بيانا، والكلام وإن كان ظاهرا فهو يحتمل زيادة البيان، ولكنه لا يحتمل من الحكم ما هو خلاف موجبه، والتعليل ليحصل به زيادة البيان، فلهذا جوزنا تعليل النص بوصف يتعدى إلى ما فيه نص آخر لاثبات الزيادة فيه، ولكنا نقول: الحكم الثابت بالتعليل في المحل الذي فيه نص إما أن يكون موافقا للحكم الثابت فيه بذلك النص أو مخالفا له، وعند الموافقة لا يفيد هذا التعليل شيئا، لان الحكم في ذلك الموضع مضاف إلى النص الوارد فيه فلا يصير
بتعليل نص آخر مضافا إلى العلة، كما لا يصير الحكم في النص المعلول مضافا إلى العلة بعد التعليل كما قررنا، وإن كان مخالفا له فهو باطل، لان التعليل في معارضة النص أو فيما يبطل حكم النص باطل بالاتفاق، وإن كان زائدا فيه فهو مغير أيضا بحكم ذلك النص، لان جميع الحكم قبل التعليل في ذلك الموضع ما أوجبه النص الوارد فيه وبعد التعليل يصير بعضه والبعض غير الكل، فعرفنا أنه لا يخلو هذا التعليل من أن يكون مغيرا حكم النص، وتبين بهذا أن الكلام في هذا الفصل بناء على ما قدمنا أن الزيادة على النص عندنا بمنزلة النسخ، فكما لا يجوز إثبات نسخ المنصوص بالتعليل بالرأي فكذلك لا يجوز إثبات الزيادة فيه.
ثم بيان قولنا: إن شرط التعليل تعدية حكم النص بعينه في مواضيع، منها أنا لا نجوز تعليل نص الربا في الاشياء الاربعة بالطعم، لان الحكم في النصوص كلها إثبات حرمة متناهية بالتساوي، وصفة الطعم توجب تعدية الحكم إلى محال تكون الحرمة فيها مطلقة غير متناهية، وهي المطعومات التي لا تدخل تحت المعيار، فعرفنا أن هذا الوصف لا يوجب تعدية حكم النص بعينه، إذ الحرمة المتناهية غير الحرمة المؤبدة، ألا ترى أن الحرمة الثابتة بالرضاع والمصاهرة غير الحرمة الثابتة بالتطليقات الثلاث، ولهذا قلنا:
إن النقود لا تتعين في العقود بالتعيين، بخلاف ما يقوله الشافعي إنها متعينة في الملك وتعيينها في العقد مفيد فتتعين بالتعيين كالسلع.
وهذا لان هذا التعليل لا يوجب تعدية حكم الاصل بعينه، فحكم البيع في السلع وجوب الملك به فيها لا وجودها في نفسها، ولهذا لا بد من قيامها في ملك البائع عند العقد ليصح العقد، وحكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها بالعقد،
ولهذا لا يشترط قيام الثمن في ملك المشتري عند العقد لصحة العقد، ويجوز العقد بدون تعيينه لا على اعتبار أنه بمنزلة السلع، ولكن يسقط اعتبار وجوده بطريق الرخصة، فإن هذا الحكم فيما وراء موضع الرخصة ثابت حتى يجوز الاستبدال به قبل القبض، ولا يجب جبر النقص المتمكن فيه عند عدم التعيين بذكر الاجل ولا بقبض ما يقابله في المجلس بخلاف السلم، فعرفنا أن الحكم الاصلي في الثمن ما بينا، وفي التعيين تغيير لذلك الحكم وجعل ما هو الركن شرطا، وأي التغيير أبلغ من هذا.
فتبين بهذا أنه ليس في هذا التعليل تعدية حكم النص بعينه بل إثبات حكم آخر في الفرع، ولهذا قلنا إن إظهار الذمي باطل، لان حكم الظهار في حق المسلم أنه يثبت به حرمة متناهية بالكفارة، فتعليل هذا الاصل بما يوجب تعدية الحكم إلى الذمي يكون باطلا، لانه لا يثبت به حكم الاصل بعينه وهو الحرمة المتناهية، فإن الذمي ليس من أهل الكفارة مطلقا.
وبيان قولنا: إلى فرع: هو نظيره في فصول، منها ما بينا أنه لا يجوز تعليل النص الوارد في الناسي بالعذر ليتعدى الحكم به إلى الخاطئ والمكره، لان الفرع ليس بنظير للاصل، فعذرهما دون عذر الناسي فيما هو المقصود بالحكم، لان عذر الخاطئ لا ينفك عن تقصير من جهته بترك المبالغة في التحرز، وعذر المكره باعتبار صنع هو مضاف إلى العباد فلا تجوز تعدية الحكم للتعليل إلى ما ليس بنظير به.
وكذلك قلنا: شرط النية في التيمم لا يجوز تعليله بأنه طهارة حكمية ليتعدى الحكم به إلى الوضوء، فإن الفرع ليس بنظير الاصل في كونه طهارة، لان التيمم باعتبار الاصل تلويث وهو لا يكون رافعا للحدث بيقين بخلاف الطهارة بالماء، ولهذا أمثلة كثيرة.
فإن قيل: فقد أوجبتم الكفارة بالاكل والشرب في رمضان على طريق تعدية حكم النص الوارد في الجماع إليه مع أن الاكل والشرب ليس بنظير للجماع لما في الجماع من الجناية على محل الفعل، ولهذا يتعلق به الحد رجما في غير الملك وذلك لا يوجد في الاكل والشرب، وأثبتم حرمة المصاهرة بالزنا بطريق تعدية الحكم من الوطئ الحلال إليه وهو ليس بنظير له فلان الاصل حلال يثبت به النسب والزنا حرام لا يثبت به النسب، وكذلك أثبتم الملك الذي هو حكم البيع بالغصب وهو ليس بنظير له، فالبيع مشروع والغصب عدوان محض وهو ضد المشروع.
قلنا: أما في مسألة الكفارة فنحن ما أوجبنا الكفارة بطريق التعليل بالرأي، فكيف يقال هذا ! ومن أصلنا أن إثبات الكفارات بالقياس لا يجوز خصوصا في كفارة الفطر فإنها تنزع إلى العقوبات كالحد، ولكن إنما أوجبنا الكفارة بالنص الوارد بلفظ الفطر، وهو قوله عليه السلام: من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر ثم قد بينا أنهما نظيران في حكم الصوم فإن ركن الصوم هو الكف عن اقتضاء الشهوتين، ووجوب الكفارة باعتبار الجناية على الصوم بتفويت ركنه على أبلغ الوجوه لا باعتبار الجناية على المحل، وفي الجناية على الصوم هما سواء، ووجوب الكفارة باعتبار الفطر (المفوت) لركن الصوم صورة ومعنى، والجماع آلة لذلك كالاكل والشرب.
وما هذا إلا نظير إيجاب القصاص في القتل بالسهم والسيف، فإن القصاص يجب بالقتل العمد والسيف آلة لذلك الفعل، كالسهم، فلا يكون ذلك بطريق تعدية الحكم من محل إلى محل، إنما التعدية فيما قاله الخصم إن الكفارة تجب بجماع الميتة والبهيمة.
وعندنا هذا التعليل باطل، لان جماع الميتة والبهيمة ليس نظير جماع الاهل في تفويت ركن الصوم، فإن فوات الركن معنى بما تميل إليه
الطباع السليمة لقصد قضاء الشهوة، وذلك يختص بمحل مشتهى وفرج الميتة والبهيمة ليس بهذه الصفة، فكان هذا تعليلا لتعدية الحكم إلى ما ليس
بنظير للاصل فكان باطلا.
فأما مسألة الزنا فالاصل في ثبوت الحرمة ليس هو الوطئ بالولد الذي يتخلق من الماءين إذا اجتمعا في الرحم، لانه من جملة البشر له من الحرمات ما لغيره من بني آدم، ثم تتعدى تلك الحرمة إلى الزوجين باعتبار أن انخلاق الولد كان من مائهما، فيثبت معنى الاتحاد بينهما بواسطة الولد، فيصير أمهاتها وبناتها في الحرمة عليه كأمهاته وبناته، ويصير آباؤه وأبناؤه في كونها محرمة عليهم كآبائها وأبنائها، ثم يقام ما هو السبب لاجتماع الماءين في الرحم وهو الوطئ مقام حقيقة الاجتماع لاثبات هذه الحرمة، وذلك بوطئ يختص بمحل الحرث، ولا معتبر بصفة الحل في هذا المعنى، ولا أثر لحرمة الوطئ في منع هذا المعنى الذي لاجله أقيم هذا السبب مقام ما هو الاصل في إثبات الحرمة، إلا أن إقامة السبب مقام ما هو الاصل فيما يكون مبنيا على الاحتياط وهو الحرمة والنسب ليس بنظيره في معنى الاحتياط، فلهذا لا يقام الوطئ مطلقا مقام ما هو الاصل حقيقة في إثبات النسب، ولا يدخل على هذا أن هذه الحرمة لا تتعدى إلى الاخوات والعمات على أن يجعل أخواتها كأخواته في حقه، لان أصل الحرمة لا يمكن إثباته بالتعليل بالرأي، وإنما يثبت بالنص، والنص ما ورد بامتداد هذه الحرمة إلى الاخوات والعمات، فتعدية الحرمة إليهما تكون تغييرا لحكم النص، وقد بينا أن ذلك لا يجوز بالتعليل.
وعلى هذا فصل الغصب، فإنا لا نوجب الملك به حكما للغصب، كما نوجبه بالبيع، وإنما نثبت الملك به شرطا للضمان الذي هو حكم الغصب، وذلك الضمان حكم مشروع كالبيع، وكون الاصل مشروعا
يقتضي أن يكون شرطه مشروعا.
وبيان قولنا: ولا نص فيه: في فصول، منها أنا لا نجوز القول بوجوب الكفارة في القتل العمد بالقياس على القتل الخطأ، لانه تعليل الاصل لتعدية الحكم إلى فرع فيه نص على حدة.
ولا نجوز القول بوجوب الدية في العمد المحض بالقياس على الخطأ لهذا المعنى.
ولا نوجب الكفارة في اليمين الغموس بالقياس على اليمين المعقودة على أمر في المستقبل لهذا المعنى أيضا.
ولا نشترط صفة الايمان فيمن تصرف إليه الصدقات سوى الزكاة بالقياس على الزكاة،
لما فيه من تعليل الاصل لتعدية الحكم إلى ما فيه نص آخر.
ولا نشترط الايمان في الرقبة في كفارة الظهار واليمين بالقياس على كفارة القتل، لان فيه تعليل الاصل لتعدية الحكم به إلى محل فيه نص آخر، وفيه تعرض لحكم النص الآخر بالتغيير فإن الاطلاق غير التقييد، وبعد ما ثبتت الرقبة مطلقا في كفارة اليمين والظهار فإثبات التقييد فيه بالايمان يكون تغييرا، كما أن إثبات صفة الاطلاق في المقيد يكون تغييرا، فإن الحرمة في الربائب لما تقيدت بالدخول، كان تعليل أمهات النساء لاثبات صفة الاطلاق في حرمة الربائب يكون تغييرا لا يجوز المصير إليه بالرأي، فكذلك إثبات التقييد فيما كان مطلقا بالنص.
وبيان الفصل الرابع، وهو ما قلنا: إن الشرط أن يبقى حكم النص بعد التعليل في الاصل على ما كان قبله، فلانه لما ثبت أن التعليل لا يجوز أن يكون مغيرا حكم النص في الفروع ثبت بالطريق الاولى أنه لا يجوز أن يكون مغيرا حكم الاصل في نفسه، ففي كل موضع لا يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان قبله، فذلك التعليل يكون باطلا، لكونه مغيرا لحكم
الاصل، ولهذا لم نجوز التعليل في قبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة بالقياس على المحدود في سائر الجرائم بعلة أنه محدود في كبيرة، لان بعد هذا التعليل لا يبقى حكم النص الوارد فيه على ما كان قبله.
فإن قيل: هذا التعليل يكون هو ساقط الشهادة بالنص أبدا ويكون ذلك متمما لحده، وبعد التعليل يتغير هذا الحكم، فإن الجلد قبل هذا التعليل يكون بعض الحد في حقه وبعده يكون تمام الحد، فيكون تغييرا على نحو ما قلنا في التغريب: إن الجلد إذا لم يضم إليه التغريب في زنا البكر يكون حدا كاملا، وإذا ضم إليه التغريب يكون بعض الحد.
وكذلك تعليل الشافعي في إبطال شهادته بنفس القذف بالقياس على سائر الجرائم باطل، لانه تغيير للحكم بالنص، فإن مدة العجز عن إقامة أربعة من الشهداء بعد القذف ثابت بالنص لاقامة
الجلد وإسقاط الشهادة، فكان إثباته بنفس القذف بدون اعتبار تلك المدة بطريق التعليل باطلا، لان حكم النص لا يبقى بعد التعليل على ما كان قبله.
وكذلك القول بسقوط شهادة الفاسق أصلا بالقياس على المحدود في القذف أو على العبد والصبي باطل، لان الحكم الثابت بالنص في حق الفاسق التوقف في شهادته، وبعد تعيين جهة البطلان فيه لا يبقى التوقف، فحكم النص بعد هذا التعليل لا يبقى على ما كان قبله.
وكذلك قلنا: الفرقة بين الزوجين لا تقع بلعان الزوج، لان الحكم الثابت بالنص اللعان من الجانبين، وهي شهادات مؤكدة بالايمان وليس فيه ما يوجب الفرقة بينهما، وقد ثبت بالنص أنهما لا يجتمعان أبدا، وذلك أيضا لا يقتضي زوال الملك به كما بعد إسلام المرأة قبل إسلام الزوج، فإثبات حكم الفرقة بقذف الزوج عند لعانه لا يجوز بطريق التعليل، لانه لا يبقى حكم النص بعد هذا التعليل على ما كان قبله، فقبله المذكور جميع الحكم،
وبعده يكون بعض الحكم، إلا أن بعد ما فرغا من اللعان يتحقق فوات الامساك بالمعروف ما داما مصرين على ذلك، واستحقاق الفرقة عند فوات الامساك بالمعروف يثبت موقوفا على قضاء القاضي به كما بعد إسلام أحد الزوجين إذا أبى الآخر الاسلام.
وكذلك قلنا: إذا كذب الملاعن نفسه وضرب الحد جاز له أن يتزوجها، لان الثابت بالنص أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا وبعد الاكذاب لا يكون متلاعنا، بدليل أنه يقام عليه حد القذف فلا يجتمع اللعان والحد بقذف واحد، فمن ضرورة القول بإقامة الحد عليه أن لا يبقى ملاعنا، ولهذا لو أكذب نفسه قبل اللعان فإنه يقام الحد عليه ولا يلاعنها، فإذا خرج من أن يكون ملاعنا بإكذابه نفسه قلنا إن كان قبل قضاء قاضي بالفرقة لم يفرق بينهما، وإن كان بعد القضاء جاز له أن يتزوجها، لانا لو بقينا الحرمة بالقياس على الحرمة الثابتة بالرضاع والمصاهرة لم يبق حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله، فإن قبل التعليل كان الثابت بالنص