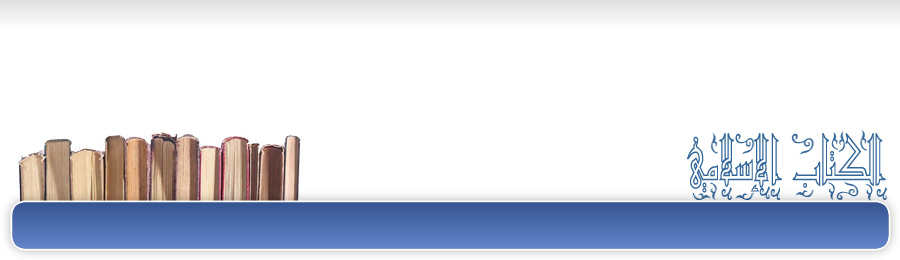كتاب : المحصول في علم الأصول
المؤلف : محمد بن عمر بن الحسين الرازي
الباب الأول في مباحث الحكم وفيه مسائل
المسألة الأولىاتفق أكثر المتكلمين على صحة القياس في العقليات ومنه نوع يسمونه إلحاق الغائب بالشاهد
قالوا ولابد من جامع عقلى والجامع أربعة العلة والحد والشرط والدليل أما الجمع بالعلة فكقول أصحابنا إذا كانت العالمية شاهدا فيمن له العلم معللة بالعلم وجب أن يكون كذلك غائبا
وأما الجمع بالحد فكقول القائل حد العالم شاهدا من له العلم فيجب طرد الحد غائبا
وأما الجمع بالشرط فكقولنا العلم مشروط بالحياة شاهدا فكذلك غائبا
وأما الجمع بالدليل فكقولنا التخصيص والأحكام يدلان على العلم والإرادة شاهدا فكذلك غائبا
واعلم أنه لما كان الجمع بالعلة أقوى الوجوه وجب علينا أن نتكلم فيه فنقول اعتماد القياس على مقدمتين
إحداهما أن الحكم ثبت في الأصل لعلة كذا
وثانيتهما أن تلك العلة حاصلة بتمامها في الصورة الآخرى
فهاتان المقدمتان إن حصل العلم بهما حصل العلم بثبوت الحكم في الفرع
وإن حصل الظن بهما حصل الظن بثبوت الحكم في الفرع
وإنما قلنا إنه يلزم من حصول العلم بتينك المقدمتين حصول العلم بالنتيجة وذلك لأنه إذا ثبت أن ذلك المعنى مؤثر في ذلك الحكم ثم ثبت ذلك المعنى في صورة أخرى فنقول كون ذلك المعنى مؤثرا في ذلك الحكم في تلك الصورة إما أن يعتبر في تلك المؤثرية كونه حاصلا في تلك الصورة أو كونه غير حاصل في هذه الصورة
وأما أن لا يعتبر فيها ذلك
فإن كان الأول لم يكن ذلك المعنى اتمام العلة لأن مرادنا من تمام العلة كل ما لابد منه في المؤثرية
فإذا كان لا بد من قيد كون المعنى هناك أو قيد كونه ليس هناك فذاك المعنى ليس وحده تمام العلة على التفسير الذي ذكرناه
وإن كان الثاني فتمام المؤثر حصل في الأصل مستلزما للحكم وفي الفرع غير مستلزم للحكم مع أنه لم يختلف حاله ألبتة في الصورتين لا بحسب زوال شيء عنه ولا بحسب انضمام شيء إليه فيلزم حينئذ ترجح أحد طرفي الممكن المساوى على الآخر من غير مرجح وهو محال
فثبت بهذا البرهان الباهر أنه يلزم من العلم بتينك المقدمين حصول العلم بثبوت الحكم في الفرع
وإذا ثبت هذا ظهر أن بتقدير حصول هاتين المقدمتين في العقليات كان القياس حجة فيها
فإن قلت حاصل الكلام فيما ذكرته هو الاستدلال بحصول العلة على حصول المعلول وليس هو بقياس
قلت بل هذا هو القياس فإنا إذا رأينا الحكم حاصلا في صورة معية ثم قامت الدلالة على أن المؤثر في ذلك الحكم هو الوصف الفلانى ثم قامت الدلالة على أن ذلك الوصف حاصل في هذه الصورة الثانية لزم القطع بحصول الحكم في الصورة الثانية
بل تحصيل اليقين بهاتين المقدمتين أمر صعب وذلك لأنا وإن بينا أن الحاصل في الفرع مثل الحاصل في الأصل فالمثلان لابد وأن يتغايرا بالتعين والهوية وإلا فهذا عين ذاك وذاك عين هذا فيكون كل واحد منهما عين الآخر فالاثنان واحد هذا خلف
وإذا حصل التغاير بالتعين والهوية فلعل ذلك التعين في أحد الجانبين جزء العلة أو شرط العلية وفي الجانب الآخر يكون مانعا من العلية ومع هذا الاحتمال لا يحصل القطع
وأعلم أن للمتكلمين طرقا في تعيين العلة
أحدهاالتقسيم الذي لا يكون منحصرا
فإذا قيل لهم لم لا يجوز وجود قسم آخر
قالوا اجتهدنا في طلبه فما وجدناه وعدم الوجدان بعد الاستقصاء في الطلب يدل على عدم الوجود كالمبصر إذا طلب شيئا في الدار ونظر إلى جميع جوانبها في النهار فلم يجد قطع بالعدم
وهذا ضعيف إذ رب موجود ما عرفناه بعد الطلب والقياس على نظر العين قياس من غير جامع وبتقدير ذكر الجامع فهو إثبات القياس بالقياس وهو باطل
وثانيها الدوران الخارجى وقد تقدم بيان أنه لا يفيد الظن فضلا عن اليقين
وثالثها الدوران الذهنى كقولهم متى عرفنا كون التكليف أمرا بالمحال عرفنا قبحه وإن لم نعرف شيئا آخر ومتى لم نعرف كونه أمرا بالمحال لم نعرف قبحه وإن عرفنا سائر صفاته
فإذن العلم بالقبح دائر مع العلم بكونه أمرا بالتكليف بالمحال في الذهن
فهذا الدوران الذهنى يفيد الجزم بأن المؤثر في القبح هو نفس كونه أمرا بالتكليف
فنقول كلامكم يشتمل على أمرين
أحدهما أنه لما لزم من العلم بكونه أمرا بالمحال العلم بقبحه لزم أن يكون كونه أمرا بالمحال علة لقبحه
والثاني أنه لما لم يلزم من العلم بسائر صفاته العلم بكونه قبيحا وجب
أن لا يكون سائر صفاته علة لكونه قبيحا وأنتم منازعون في هذين المقامين فلا بد من الدلالة عليهما فإن العلم بهما ليس من العلوم الضرورية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين وما رأيت أحدا من المتكلمين ذكر في تقرير هذين المقامين شيئا
على أن الأول منقوض بجميع الإضافات فإنا متى علمنا كون هذا الشخص أبا علمنا كون هذا الشخص الآخر أبنا وكذا بالعكس مع أنه يستحيل أن يكون كون هذا أبا لذاك علة لكون ذلك أبنا لهذا لأن المضافين معا والعلة قبل المعلول والمع لا يكون قبل
وأما الثاني فلأنه لا يمكن القطع بأنا إذا عرفنا سائر صفاته فإنه لا يحصل العلم عند ذلك بكونه قبيحا إلا إذا عرفنا كل صفة فكيف يمكننا أن نقطع بأنا عرفنا كل صفاته فإنا إذا جوزنا أن يكون من الصفات ما لم نعرفه جوزنا في بعض تلك الصفات التي لم نعرفها أن يجب عند العلم به العلم بكونه قبيحا ومع هذا التجويز لا تتم هذه المقدمة
سلمنا أنه لا يلزم من العلم بسائر الصفات العلم بكونه قبيحا
فلم يدل هذا القدر على أن سائر الصفات لا يجوز أن تكون مؤثرة في القبح
واعلم أن الكلام في تقرير هاتين المقدمتين مأخوذ من الفلاسفة فإنهم زعموا أن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول
فعلى هذا كل ما كان علة للقبح يلزم من العلم به العلم بالقبح
وزعموا أن العلم اليقينى بوجود المعلول لا يحصل إلا من العلم بعلته فلما لزم الجزم بالقبح عند العلم بكونه أمرا بالتكليف بالمحال علمنا أن علة القبح ذلك ولكنا قد نقلنا في كتبنا الكلامية دلائلهم على هاتين المقدمتين وبينا ضعفهما وسقوطهما فلا نعيدهما هاهنا وبالله التوفيق
المسألة الثانية
الحق جواز القياس في اللغات وهو قول ابن سريج مناونقل ابن جنى في الخصائص أنه قول أكثر علماء العربية كالمازني وأبي علي الفارسي
وأما أكثر أصحابنا وجمهور الحنفية فينكرونه
لنا وجوه
الأول أنا رأينا أن عصر العنب لا يسمى خمرا قبل الشدة الطارئة فإذا حصلت تلك الشدة سميت خمرا فإذا زالت الشدة مرة أخرى زال الاسم والدوران يفيد ظن العلية فيحصل ظن أن العلة لذلك الاسم هو الشدةثم رأينا الشدة حاصلة في النبيذ فيحصل ظن أن علة هذا الاسم حاصلة في النبيذ ويلزم من ظن حصول علة الاسم ظن
حصول الاسم فإذا حصل ظن أنه مسمى بالخمر وعلمنا أو ظننا أن الخمر حرام حصل ظن أن النبيذ حرام والظن حجة فوجب الحكم بحرمة النبيذ
فإن قيل الدوران إنما يفيد ظن العلية فيما يحتمل العلية وهاهنا لم يوجد الاحتمال لأنه ليس من بين شيء من الألفاظ وشيء من المعاني مناسبة أصلا فأستحال أن يكون شيء من المعاني داعيا للواضع إلى تسميته بذلك الاسم وإذا لم يوجد احتمال العلية هاهنا لم يكن الدوران هاهنا مفيدا لظن العلية
سلمنا أنه حصل ظن العلية ولكن إنما يلزم من حصول العلة في الفرع حصول ذلك الحكم إذا اثبت أن تلك العلة إنما صارت علة لأن الشارع جعلها علة ألا آخر أنه لو قال أعتقت غانما لسواده فإذا كان له عبد آخر أسود لم يعتق عليه لأن ما يجعله الإنسان علة لحكم لا يجب أن يتفرع عليه الحكم أينما وجد فكذا هاهنا لا يلزم من كون الشدة علة لذلك الاسم حصول ذلك الاسم أينما حصلت الشدة إلا إذا عرفنا أن واضع الاسم هو الله تعالى
والجواب عن الأول أنه لا يمكن جعل المعنى علة للاسم إذا فسرنا العلة
بالداعي أو المؤثر أما إذا فسرنا بالمعرف فلا يمتنع كما أن الله تعالى جعل الدلوك علة لوجوب الصلاة لا بمعنى كون الدلوك مؤثرا أو داعيا بل بمعنى أن الله تعالى جعله معرفا فكذا هاهناوعن الثاني أنا بينا أن اللغات توقيفية
الثاني وهو الذي أعتمد عليه المازني وأبو علي الفارس رحمهما الله أنه لا خلاف بين أهل اللغة أن كل فاعل رفع وكل مفعول نصب وكذلك القول في جميع وجوه الإعراب وأن كل ضرب منها اختص بأمر انفرد به ولم يثبت ذلك إلا قياسا لأنهم لما وصفوا
بعض الفاعلين به واستمروا على ذلك علم أنه ارتفع الفاعل لكونه فاعلا وانتصب المفعول لكونه مفعولا
فإن قلت كيف يصح ذلك وقد وجد المفعول غير منتصب وكذا الفاعل قد لا يرتفع لعارض
قلت تخلف الحكم عن العلة لمانع لا يقدح في العلية عند من يقول بتخصيص العلة
ومن لا يقول به يجعل هذا القيد العدمي جزءا من العلة
الثالث وهو أن أهل العربية أجمعوا على أن ما لم يسم فاعله إنما ارتفع لكونه شبيها بالفاعل في إسناد الفعل إليه ولم تزل فرق النحاة من الكوفيتين والبصريين يعللون في الأحكام الإعرابية بأن هذا يشبه ذاك في كذا فوجب أن يشبهه في الإعراب وإجماع أهل اللغة في المباحث اللغوية حجة
الرابع أن نتمسك بعموم قوله تعالى فاعتبروا فإنه يتناول كل الأقيسة واعتمادهم في الفرق على أن المعاني لا تناسب الألفاظ فأمتنع جعل المعنى علة للاسم بخلاف الأحكام الشرعية فان المعاني قد تناسبها لكنا قد بينا سقوط هذا الفرق
واحتج المخالف بأمور
أحدهاقوله تعالى وعلم آدم الاسماء كلها دلت الآية على أنها بأسرها
توقيفية فيمتنع في شيء منها أن يثبت بالقياس
وثانيها
أن أهل اللغة لو صرحوا وقالوا قيسوا لم يجز القياس كما إذا قال أعتقت غانما لسواده ثم قال قيسوا فإنه لا يجوز القياس فإذا لم يجز القياس عند التصريح بالأمر
بالقياس فلأن لا يجوز ذلك مع أنه لم ينقل عن أهل اللغة نص في ذلك كان أولى
وثالثها أن القياس إنما يجوز عند تعليل الحكم في الأصل وتعليل الأسماء غير جائز لأنه لا مناسبة بين شيء من الأسماء وبين شيء من المسميات وإذا لم يصح التعليل لم يصح القياس ألبتة
ورابعها أن وضع اللغات ينافي جواز القياس فإنهم سموا الفرس الأسود أدهم ولم يسموا الحمار بن الأسود به وسموا الفرس الأبيض أشهب ولم يسموا الحمار الأبيض به وسموا صوت الفرس صهيلا صوت الحمار نهيقا صوت الكلب نباحا
وأيضا القارورة إنما سميت بهذا الاسم لأجل الاستقرار ثم إن ذلك المعنى حاصل في الحياض والأنهار مع أنها لا تسمى بذلك
والخمر إنما سميت بهذا الاسم لمخامرتها العقل ثم المخامرة حاصلة في الأفيون وغيره ولا يسمى خمرا
والجواب عن الأول
أنه ليس في الآية أنه تعالى علم آدم الأسماء كلها توقيفا فيجوز أن يكون علم البعض توقيفا والبعض تنبيها بالقياسولأنه يجوز أن يدرك آدم علمها توقيفا ونحن نعلمها قياسا كما أن جهات القبلة قد تدرك حسا وقد تدرك اجتهادا
وعن الثاني أنا ندعى أنه نقل إلينا بالتواتر عن أهل اللغة أنهم جوزوا القياس ألا ترى أن جميع كتب النحو والتصريف والاشتقاق مملوءة من الأقيسة وأجمعت الأمة على وجوب الأخذ بتلك الأقيسة فإنه لا نزاع أنه لا يمكن تفسير القرآن والأخبار إلا بتلك القوانين فكان ذلك إجماعا معلوما بالتواتر
وعن الثالث ما قد بينا أنا نفسر العلة بالمعرف لا بالداعي ولا المناسب وحينئذ لا يقدح عدم المناسبة فيه
وعن الرابع أن أقصى ما في الباب أنهم ذكروا صورا لا يجرى فيها القياس
وذلك لا يقدح في العمل بالقياس كما أن النظام لما ذكر صورا كثيرا في الشرع لا يجرى فيها القياس لم يدل ذلك على المنع من القياس في الشرع
المسألة الثالثة
المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسبابوالدليل عليه أنا إذا قسنا اللواط مثلا على الزنا في كونه موجبا للحد فإما أن نقول أن كون الزنا موجبا للحد لأجل وصف مشترك بينه وبين اللواط
وأما أن لا نقول ذلك
فإن كان الأول كان الموجب للحد هو ذلك المشترك
وحينئذ يخرج الزنا واللواط عن كونهما موجبين للحد لأن
الحكم لما أسند إلى القدر المشترك استحال مع ذلك إسناده إلى خصوصية كل واحد منهما
فإذن شرط القياس بقاء حكم الأصل والقياس في الأسباب ينافي بقاء حكم الأصل بخلاف القياس في الأحكام فإن ثبوت الحكم في الأصل لا ينافي كونه معللا بالقدر المشترك بينه وبين الفرع
وأما إن قيل كون الزنا موجبا للحد ليس لأجل وصف مشترط بينه وبين اللواط استحال قياس اللواط عليه لأنه لا بد في القياس من الجامع
فإن قلت الجامع بين الوصفين لا يكون له تأثير في الحكم بل تأثيره في علية الوصفين وأما الحكم فإنما يحصل من الوصفين
قلت هذا باطل لأن ما صلح لعلية العلة كان صالحا لعلية الحكم فلا حاجة حينئذ إلى الوساطة
المسألة الرابعة
الحكم الذي طلب إثباته بالقياس أما النفى الأصلي أو الحكم الثبوتى المعلوم أو المظنون فلنتكلم في هذه الثلاثة فنقولاختلفوا في أن النفى الأصلي هل يمكن التوصل إليه بالقياس أو لا بعد اتفاقهم على أن استصحاب حكم العقل كاف فيه
والحق أنه يستعمل فيه قياس الدلالة لا قياس العلة
أما قياس الدلالة فهو أن يستدل بعدم اثار الشيء وعدم خواصه على عدمه
وأما تعذر قياس العلة فلأن الانتفاء الأصلي حاصل قبل الشرع فلا يجوز تعليه بوصف يوجد بعد ذلك
ولقائل أن يقول علة الشرع لا معنى لها إلا المعرف وتأخر الدليل عن المدلول جائز
واعلم أن هذا الكلام يختص ب العدم فأما الإعدام فإنه حكم شرعي يجرى فيه القياس
وأما الذي طريقه العلم فقد اختلفوا في أنه هل يجوز استعمال القياس فيه
وعندى أن هذا الخلاف لا ينبغى أن يقع في الجواز الشرعي فإنه لو أمكن تحصيل اليقين بعلة الحكم ثم تحصيل اليقين بأن تلك العلة حاصلة في هذه الصورة لحصل العلم اليقينى بأن حكم الفرع مثل حكم الأصل بل البحث ينبغى أن يقع في أنه هل يمكن تحصيل هذين اليقينين في الأحكام الشرعية أم لا
وأما الذي طريقه الظن فلا نزاع في جواز استعمال القياس فيه
المسألة الخامسة
اختلفوا في أنه هل يمكن إثبات أصول العبادات بالقياس أم لا فقال الجبائى والكرخي لا يجوز وبنى الكرخي عليه أنه لا يجوز إثبات الصلاة بإيماء الحاجب بالقياسواعلم أن هذا الخلاف يمكن حمله على وجهين
الأول أن يقال الصلاة بإيماء الحاجب لو كانت مشروعة لوجب على النبي صلى الله عليه و سلم أن يبينها بيانا شافيا وينقله أهل التواتر إلينا حتى يصير ذلك معلوما لنا قطعا فلما لم يكن كذلك علمنا أن القول بها باطل
والثاني أن يقال لا ندعي أنها لو كانت مشروعة لحصل العلم
بها يقينا ولكنا مع ذلك نمنع من استعمال القياس فيه
أما الأول فهو باطل بالوتر فإنه واجب عندهم مع أنه لم يعلم وجوبه قطعا
فإن قلت إذا جوزت في ذلك أن لا يبلغ مبلغ التواتر فلعله عليه الصلاة و السلام أوجب صوم شوال ولم ينقل ذلك بالتواتر
قلت المعتمد في نفيه الإجماع
وأما الثاني فتحكم محض لأنه إذا جاز الاكتفاء فيه بالظن فلم لا يكتفى بالقياس
ثم إنا نستدل على جوازه بعموم قوله تعالى فاعتبروا أو بما أنه يفيد ظن الضرر فيكون العمل به واجبا
المسألة السادسة
مذهب الشافعي رضى الله عنه أنه يجوز إثبات التقديرات والكفارات والحدود والرخص بالقياسوقال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله إنه لا يجوز
وحاصل الخلاف أنه هل في الشريعة جملة من المسائل يعلم أنه لا يجوز استعمال القياس فيها أو ليس كذلك بل يجب البحث عن كل مسألة أنه هل يجرى القياس فيها أم لا
لنا التمسك بعموم قوله تعالى فاعتبروا وبإطلاق قول معاذ أجتهد مع أن الرسول صلى الله عليه و سلم صوبه في إطلاقه وبأنه يجب العمل بالضرر المظنون
فإن ادعوا أنه لا يمكننا وجدان العلة في هذه المسائل فذلك إنما يظهر بالبحث عن كل واحدة من هذه المسائل فإن وجدنا العلة فيها صح القياس وإلا فلا
ولكن هذا المعنى غير مختص بهذه المسائل بل كل مسألة لا نجد العلة فيها تعذر علينا القياس
واعلم أن الشافعي رضى الله عنه ذكر مناقضتهم في هذا الباب فقال أما الحدود فقد كثرت أقيستهم فيها حتى تعهدوها إلى الاستحسان فإنهم زعموا في شهود الزوايا أن المشهود عليه يجب رجمه بالاستحسان
مع أنه على خلاف العقل فلأن يعمل بما وافق العقل كان أولى
وأما الكفارات فقد قاسوا الإفطار بالأكل على الإفطار بالوقاع وقاسوا قتل الصيد ناسيا على قتله عمدا مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
فإن قلت ليس هذا بقياس وإنما هو استدلال على موضع الحكم بحذف الفوارق الملغاة
قلت أنكم لما لم تبينوا أن الحكم في الأصل يجب أن يكون معللا وأن العلة إما الذي به الاشتراك بين الأصل والفرع أو الذي به الامتياز
وباطل أن لا يكون معللا وباطل أن يكون معللا بما فيه الامتياز فوجب التعليل بما به الاشتراك ويلزم من حصول ذلك
المعنى في الفرع حصول الحكم فيه وهذا نفس القياس واستخراج العلة بطريق السبر والتقسيم
وأما المقدرات فقد قاسوا فيها حتى إنهم ذهبوا إلى تقديراتهم في الدلو والبئر
وأما الرخص فقد قاسوا فيها وبالغوا فإن الاقتصار على الأحجار في الاستنجاء من أظهر الرخص ثم حكموا بذلك في كل النجاسات نادرة كانت أو معتادة وانتهوا فيها إلى نفي إيجاب استعمال الأحجار
وقالوا أيضا العاصي بسفره يترخص فأثبتوا
الرخصة بالقياس مع أن القياس ينفيها لأن الرخصة إعانة والمعصية لا تناسب الإعانة
احتج الخصم بقوله عليه الصلاة و السلام ادرؤا الحدود بالشبهات والقياس لا يفيد القطع فتحصل الشبهة
وأما المقدرات فهي كالنصب في الزكوات والمواقيت في الصلوات وقالوا العقول لا تهتدى إليها
وأما الرخص فقالوا أنها منح من الله تعالى فلا يعدل بها عن مواضعها
وأما الكفارات فإنها على خلاف الأصل لكونها منفية بالنص النافي للضرر
والجواب عنه أنها تشكل بالمسائل التي ذكرها الشافعي رضى الله عنه
ثم نقول هذه الأدلة خضت بخبر الواحد فانه يجوز إثبات هذه الأشياء بخبر الواحد مع أنه لا يفيد العلم وما لأجله صار خبر الواحد مخصصا لها قائم في القياس الخاص فوجب تخصيصها بالقياس
المسألة السابعة
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى رحمه الله ما طريقة العادة العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثره وأقل النفاس وأكثره لا يجوز إثباته بالقياس لأن أسبابها غير معلومة لا قطعا ولا ظاهرا فوجب الرجوع فيها إلى قول الصادقالمسألة الثامنة
الأمور التي لا يتعلق بها عمل لا يجوز إثباتها بالقياس كقرآن النبي صلى الله عليه و سلم وإفراده ودخوله مكة صلحاأو عنوة فإن مثل هذه الأمور تطلب لتعرف لا ليعمل بها فلا يجوز الاكتفاء فيها بالظن
المسألة التاسعة
القياس إذا ورد بخلاف النص فالنص إما أن يكون متواترا أو آحادافإن كان متواترا فالقياس أن نسخه كان مردودا وإن خصصه فقد ذكرنا الخلاف فيه في باب العموم والخصوص
وإن كان آحادا فهو ما إذا ورد خبر الواحد على خلاف القياس وقد شرحنا الحال فيه في باب الخبر
المسألة العاشرة
يجوز التعبد بالنصوص في كل الشرع فإنه يمكن أن ينص الله تعالى على أحكام الأفعال على الجملة ويدخل تفصيلها فيها كما إذا نص على حرمة الربا في كل مطعوم فيدخل فيه كل مطعوم
وأما التعبد بالقياس في الكل فمحال لأن القياس لا يصح إلا بعد ثبوت الحكم في الأصل لكن أحكام الأصول شرعية لأن العقل لا يدل إلا على البراءة الأصلية فما عداها لا يثبت إلا بالشرع فلو كانت تلك الأحكام مثبتة بالقياس لزم الدور وهو محال
الباب الثاني في شرائط الأصل
أعلم أن الحكم في المقيس عليه إما أن يكون علة وفق قياس الأصول أو على خلاف قياس الأصول فلنذكر حكم كل واحد من هذين القسمين ثم نذكر ما ظن أنه شرط في هذا الباب مع أنه ليس بشرط
القسم الأول في شرائط الأصل إذا كان حكمه على وفق قياس الأصول وهي ستة
الأول ثبوت حكم الأصل لأن القياس عبارة عن تشبيه الفرع بالأصل في الحكم وذلك لا يمكن إلا بعد ثبوت الحكم في الأصلالثاني أن يكون الطريق إلى معرفة ذلك الحكم سمعيا وهو ظاهر على مذهبنا أن جميع الأحكام لا تعرف إلا بالسمع
أما على مذهب من يثبت هذه الأحكام عقلا فقد احتجوا عليه بأنه لو كان ذلك الطريق عقليا لكانت معرفة ثبوت الحكم في الفرع عقلية فكان القياس عقليا لا سمعيا
وهذا ضعيف لأن ثبوت الحكم في الفرع يتوقف على ثبوت الحكم في الأصل وعلى كون ذلك الحكم معللا بالوصف الفلاني وعلى حصول ذلك الوصف في الفرع فبتقدير أن تكون معرفة الأول عقلية يحتمل أن تكون المعرفتان الباقيتان سمعيتين
وحينئذ لا يمكن معرفة حكم الفرع إلا بمقدمات سمعية والمبنى على السمع سمعي فيكون ثبوت الحكم في الفرع سمعيا
الثالث أن لا يكون طريق ثبوت الحكم في الأصل هو القياس لأن العلة التي يلحق بها الأصل القريب بالأصل البعيد إما أن تكون هي التي بها يلحق الفرع بالأصل القريب أو غيرها
فإن كان الأول أمكن رد الفرع إلى الأصل البعيد فيكون دخول الأصل القريب لغوا
وإن كان الثاني لزم تعليل حكم الأصل القريب بعلتين وهو محال
أما أولا فلإنا بينا أن تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين محال
وأما ثانيا فلأنه لا يمكننا إثبات الحكم في الأصل القريب إلا بأن يتوصل إليه بالعلة الموجودة في الأصل البعيد ومتى توصلنا إلى ثبوته بتلك العلة امتنع تعليله بالعلة الموجودة في الفرع لأن تلك العلة إنما عرفت بعد أن عرف تعليل الحكم بعلة أخرى ومتى عرف ذلك كانت العلة الثانية عديمة الأثر فيكون التعليل بها ممتنعا
الرابع أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل دالا بعينه على حكم الفرع وإلا لم يكن جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس
الخامس لابد وأن يظهر كون ذلك الأصل معللا بوصف معين لأن رد الفرع إليه لا يصلح إلا بهذه الواسطة
السادس قالوا يجب أن لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية لأن التعبد بالتيمم إنما ورد بعد الهجرة
والحق أن يقال لو لم يوجد على حكم الفرع دليل إلا ذلك القياس لم يجز تقدم الفرع على الأصل لأن قبل هذا الأصل لزم أن يقال كان هذا الحكم حاصلا من غير دليل وهو تكليف مالا يطاق
أو ما كان حاصلا ألبتة فيكون ذلك كالنسخ
وأما إن وجد قبل ذلك دليل أخر سوى القياس يدل على ذلك الحكم فجائز فإن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز
القسم الثاني
إذا كان الحكم في المقيس عليه على خلاف قياس فقال قوم من الشافعية والحنفية يجوز القياس عليه مطلقاوقال الكرخي لا يجوز إلا لإحدى خلال ثلاث
إحداها أن يكون قد نص على علة ذلك الحكم لأن النص كالتصريح بوجوب القياس عليه
وثانيها أن تجمع الأمة على تعليله وإن اختلفوا في تعليله فلا يجوز القياس عليه
وثالثها أن يكون القياس عليه موافقا للقياس على أصول أخرى
والحق أن يقال ما ورد بخلاف قياس الأصول إما أن يكون
دليلا مقطوعا به أو غير مقطوع به
فإن كان مقطوعا به كان أصلا بنفسه لأن مرادنا بالأصل في هذا الموضع هذا فكان القياس عليه كالقياس على غيره فوجب أن يرجح المجتهد بين القياسين
يؤكده أنه إذا لم يمنع العموم من قياس يخصه فأولى أن لا يكون القياس على العموم مانعا من قياس يخالفه لأن العموم أقوى من القياس على العموم
احتج الخصم بأن الخبر يخرج من القياس ما ورد فيه وما عداه باق على قياس
الأصولوالجواب أنه إذا أخرح ما ورد فيه ودلت أمارة على عليته اقتضى إخراج ما
شاركه في تلك العلةثم ليس بأن لا يخرج لشبهه بالأصول أولى من أن يخرج لشبهه
بالمنصوص عليه
أما إذا كان غير مقطوع به فإما أن تكون علة حكمة منصوصة أو لا تكون منصوصة
فإن لم تكن منصوصة ولا كان القياس عليه أقوى من القياس على الأصول فلا شبهة في أن القياس على الأصول أولى من القياس عليه لأن القياس على ما طريق حكمة معلوم أولى من القياس على ما طريق حكمه غير معلوم
وإن كانت منصوصة فالأقرب أنه يستوى القياسان لأن القياس على الأصول يختص بأن طريق حكمه معلوم وإن كانت علة حكمه غير معلومة
وهذا القياس طريق حكمه مظنون وعلته معلومة فكل واحد منهما قد اختص بحظ من القوة
القسم الثالث فيما جعل شرطا في هذا الباب مع أنه ليس بشرط وهو ثلاثة
الأول زعم عثمان البتى أنه لا يقاس على الأصل حتى تقوم الدلالة على جواز القياس عليهوهو باطل من ثلاثة أوجه
أحدها أن عموم قوله تعالى فاعتبروا ينفى هذا الشرط
وثانيها أنا إذا ظننا كون الحكم في الأصل معللا بوصف ثم علمنا أو ظننا حصوله في الفرع حصل ظن أن حكم الفرع مثل حكم الأصل والعمل بالظن واجب
وثالثها أن الصحابة حين استعملوا القياس في مسألة الحرام والجد وغيرها لم يعتبروا هذا الشرط
الثاني زعم بشر المريسى أن شرط الأصل انعقاد الإجماع على كون حكمه معللا أو ثبوت النص على عين تلك العلة
وعندنا أن هذا الشرط غير معتبر والدليل عليه الوجوه الثلاثة المذكورة
الثالث قال قوم الأصل المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه حتى قالوا في قوله عليه الصلاة و السلام خمس يقتلن في الحل والحرم لا يقاس عليه والحق جوازه للوجوه الثلاثة
واحتجوا بأن تخصيص ذلك العدد بالذكر يدل على نفى الحكم عما عداه
وأيضا جواز القياس عليه يبطل ذلك الحصر
والجواب يبطل ذلك بجواز القياس على الأشياء الستة في تحريم ربا الفضل وهذا أيضا دليل في أول المسألة
الباب الثالث في الفرع
وشرطه أن يوجد فيه مثل علة الحكم في الأصل من غير تفاوت ألبتة لا في الماهية ولا في الزيادة ولا في النقصان لأن القياس عبارة عن تعدية الحكم من محل إلى محل والتعدية لا تحصل إلا إذا كان الحكم المثبت في الفرع مثل المثبت في الأصلفإن قلت هذا يقتضى أن لا يكون قياس العكس حجة
قلت قد بينا في أول كتاب القياس أن قياس العكس عبارة عن التمسك بنظم التلازم ابتداءا ثم إنا نثبت مقدمته الشرطية بقياس الطرد
وأما الأمور التي اعتبرها قوم في الفرع مع أنها ليست معتبرة فهي ثلاثة
الأول قال بعضهم يجب أن يكون حصول العلة في الفرع معلوما لا مظنونا
وهذا باطل للنص والحكم والمعقول
أما النص فهو أن عموم قوله تعالى فاعتبروا يقتضى حذف هذا الشرط
وأما الحكم فهو أن الزنا والسرقة إذا ظهرا عند القاضي قضى بوجوب الحد لأن الطريق إليه شهادة الشهود وهى لا تفيد العلم
وأما المعقول فهو أنه إذا حصل ظن كون الحكم معللا بذلك الوصف ثم حصل ظن ثبوت ذلك الوصف في الفرع حصل ظن أن الحكم في الفرع مثل الحكم في الأصل والعمل بالظن واجب مطلقا على ما بيناه
الثاني قال أبو هاشم الحكم في الفرع يجب أن يكون معا ثبت جملة حتى يدل القياس على تفصيله ولولا أن الشرع ورد بميراث الجد وإلا لما استعملت الصحابة القياس في توريثه مع الإخوة وهذا باطل لأن أدلة القياس تحذف هذا القيد
الثالث أن لا يكون الفرع منصوصا عليه وهو على قسمين لأن الحكم الذي دل النص عليه إما أن يكون مطابقا للحكم الذي دل عليه القياس أو مخالفا
فإن كان الأول جاز استعمال القياس فيه عند الأكثرين لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز
ومنعه بعضهم استدلالا بأن معاذا إنما عدل إلى الاجتهاد بعد فقدان النص فدل على أنه لا يجوز استعماله عند وجوده
وأيضا فالدليل ينفى جواز العمل بالقياس لكونه اتباعا للظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا ترك العمل به فيما إذا لم يوجد النص للضرورة فيبقى حال وجود النص على مقتضى الأصل
والجواب عن الأول
أن قصة معاذ دالة على أن التمسك بالقياس عند فقدان النص جائزفأما عند وجود النص فليس فيه دليل لا على جواز ولا على بطلانه
وعن الثاني ما تقدم مرارا من أن العمل بالقياس ليس على خلاف الدليل
خاتمة لهذا الباب
هاهنا نوع آخر من القياس يستعمله أهل الزمان وهو أن يقال لو ثبت الحكم في الفرع لثبت في الأصل لأن بتقدير ثبوته في الفرع وجب أن يكون ثبوته لأجل المعنى الفلانى لمناسبته واقتران الحكم به وذلك المعنى حاصل في الأصل فيلزم ثبوت الحكم فيهفثبت أن الحكم لو ثبت في الفرع لثبت في الأصل فلما لم يثبت في الأصل وجب أن لا يثبت في الفرع
ويمكن أن يذكر ذلك على وجه آخر أسد تلخيصا وهو أن يقال ثبوت الحكم في الفرع يفضى إلى محذور فوجب أن لا يثبت
إنما قلنا انه يفضى إلى محذور لأنه لو ثبت الحكم في الفرع لكان إما أن يكون معللا بهذا الوصف الذي يشترك الفرع والأصل فيه أو لا يكون معللا به
فإن كان الأول لزم النقص لأنه غير ثابت في الأصل
وإن كان الثاني لزم النقض لأن المناسبة والاقتران دليل العلية فحصولها بدون العلية يوجب النقض وهذا آخر كلامنا في القياس وبالله التوفيق
الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام
القسم الأول في التعادل
وفيه مسألتان
المسألة الأولىاختلفوا في أنه هل يجوز تعادل الأمارتين فمنع منه الكرخى مطلقا وجوزه الباقون
ثم المجوزون اختلفوا في حكمه عند وقوعه فعند القاضى أبي بكر منا وأبي على وأبي هاشم من المعتزلة حكه التخيير
وعند بعض الفقهاء حكمه أنهما يتساقطان ويجب الرجوع إلى مقتضى العقل
والمختار أن نقول تعادل الأمارتين إما أن يقع في حكمين متناقضين والفعل واحد وهو كتعارض الأمارتين على كون الفعل قبيحا ومباحا وواجبا
وإما أن يكون في فعلين متنافيين والحكم واحد نحو وجوب التوجه إلى جهتين قد غلب على ظنه أنهما جهتا القبلة
أما القسم الأول فهو جائز في الجملة لكنه غير واقع في الشرع
أما أنه جائز في الجملة فلأنه يجوز أن يخبرنا رجلان بالنفى والإثبات وتستوى عدالتهما وصدق لهجتهما بحيث لا يكون لأحدهما مزية على الآخر
وأما أنه في الشرع غير واقع فالدليل عليه أنه لو تعادلت أمارتان على كون هذا الفعل محظورا ومباحا فإما أن يعمل بهما معا أو يتركا معا أو يعمل بإحداهما دون الثانية
والأول محال لأنه يقتضى كون الشيء الواحد في الوقت الواحد من الشخص الواحد محظورا مباحا وهو محال
والثاني أيضا محال لأنهما لما كانتا في نفسيهما بحيث لا يمكن العمل بهما ألبتة كان وضعهما عبثا والعبث غير جائز على الله تعالى
وأما الثالث وهو أن يعمل بإحداهما دون الأخرى فإما أن يعمل بإحداهما على التعيين أو لا على التعيين
والأول باطل لأنه ترجيح من غير مرجح فيكون ذلك قولا في الدين بمجرد التشهي وإنه غير جائز
والثاني أيضا باطل لأنا إذا اخيرناه بين الفعل والترك فقد أبحنا له الفعل فيكون هذا ترجيحا لأمارة الإباحة بعينها على أمارة الحظر وذلك هو القسم الذي تقدم إبطاله
فثبت أن القول بتعادل الأمارتين في حكمين متنافيين والفعل واحد يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة فوجب أن يكون باطلا
فإن قيل لم لا يجوز العمل بإحدى الأمارتين على التعيين
إما لأنها أحوط أو لأنها أخذ بالأصل
سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يكون مقتضى التعادل هو التخيير قوله القول بالتخيير إباحة الفعل فيكون ذلك ترجيحا لأمارة الإباحة
قلنا لا نسلم أن الأمر بالتخيير إباحة
بيانه أنه يجوز أن يقول الله تعالى أنت مخير في الأخذ بأمارة الإباحة وبأمارة الحظر إلا أنك متى أخذت بأمارة الإباحة فقد أبحت لك الفعل
وإن أخذت بأمارة الحرمة فقد حرمت الفعل عليك فهذا لا يكون إذنا في الفعل والترك مطلقا بل إباحة في حال وحظرا في حال أخرى
ومثاله في الشرع أن المسافر مخير بين أن يصلي أربعا فرضا وبين أن يترك ركعتين فالركعتان واجبتان ويجوز تركهما بشرط أن يقصد الترخص
وأيضا من استحق أربعة دراهم على غيره فقال تصدقت عليك بدرهمين إن قبلت وإن لم تقبل وأتيت بالأربعة قبلت الأربعة عن الدين واجب فإن شاء قبل الصدقة وأتى بدرهمين وإن شاء أتى بالأربعة عن الواجب
فكذا في مسألتنا إذا سمع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين حرم عليه الجمع بين المملوكتين
وإنما يجوز له الجمع إذا قصد العمل بموجب الدليل الثاني وهو قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم كما قال عثمان رضى الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية
سلمنا ذلك لكن هذه الدلالة إنما تتم عند تعارض أمارة الحظر والإباحة
وأما عند تعارض أمارة الحظر والوجوب إذا قلنا بالتخيير لم يلزم ترجيح إحداهما على الأخرى فدليلكم على امتناع التعادل غير متناول لكل الصور
سلمنا فساد القول بالتخيير فلم لا يجوز التساقط قوله لأنه عبث
قلنا لا نسلم ولم لا يجوز أن يقال إن لله تعالى فيه حكمة خفية لا يطلع عليها
وأيضا فهب أن التعادل في نفس الأمر ممتنع لكن لا نزاع في وقوع التعادل بحسب أذهاننا فإذا اجاز أن لا يكون التعادل الذهنى عبثا فلم لا يجوز أن لا يكون التعادل الخارجى عبثا أيضا
ثم ما ذكرتموه يشكل بما إذا أفتى مفتيان أحدهما بالحل والآخر بالحرمة واستويا في ظن المستفتى ولم يوجد الرجحان فإنهما بالنسبة إلى العامي كالأمارة
والجواب قوله لم لا يجوز العمل بإحداهما لأنه أحوط أو لأنه أصل
قلنا إن جاز الترجيح بهاتين الجهتين فوجوده ينافي التعادل وإن لم يجز فقد بطل كلامك
قوله لم قلت إن التخيير إباحة
قلت لأن المحظور هو الذي منع من فعله والمباح هو الذي لم يمنع من فعله فإذا حصل الإذن في الفعل فقد ارتفع الحجر فلا يبقى الحظر ألبتة ولا معنى للإباحة إلا ذلك
قوله ذلك الفعل محظور بشرط أن يأخذ بأمارة الحظر ومباح بشرط أن يأخذ بأمارة الإباحة
قلنا هذا باطل من وجهين
الوجه الأول هو أن أمارة الإباحة وأمارة الحظر إما أن تقوما على ذات الفعل وماهيته باعتبار واحد أو ليس كذلك بل تقوم أمارة الإباحة على الفعل المقيد بقيد وتقوم إمارة الحظر على الفعل المقيد بقيد آخر
فإن كان الثاني كان ذلك مغايرا لهذه المسألة التي نحن فيها لأن هذه المسألة هي أن تقوم الأمارتان على إباحة شيء واحد وحظره وعلى التقدير الذي قالوا قامت أمارة الإباحة على شيء وأمارة الحظر على شيء آخر فإنهم لما قالوا عند الأخذ بأمارة الحرمة يحرم الفعل عليه فمعناه أن أمارة الحرمة قائمة على حرمة هذا الفعل حال الأخذ بأمارة الحرمة وأمارة الإباحة قائمة على إباحة هذا الفعل حال عدم الأخذ بأمارة الحرمة فالأمارتان إنما قامتا على شيئين متنافيين غير متلازمين لا على شيء واحد وكلامنا في قيام الأمارتين على حكمين متنافيين في شيء واحد لا في شيئين
وإذا بطل هذا القسم ثبت القسم الأول وهو أن أمارة الحظر وأمارة الإباحة قامتا على ذات الفعل وماهيته باعتبار واحد
فإن رفعنا الحظر عن ماهية الفعل كان ذلك إباحة فيكون ترجيحا لإحدى الأمارتين بعينها
وإن لم نرفع ذلك كان ذلك حظرا فيكون ترجيحا للأمارة الأخرى بعينها
الوجه الثاني في الجواب أن نقول ما المراد بالأخذ بإحدى الأمارتين
إن عنيتم بهذا الأخذ اعتقاد رجحانها فهذا باطل لأنها إذا لم تكن راجحة كان اعتقاد رجحانها جهلا
وأيضا فنفرض الكلام فيما إذا حصل العلم بأنه لا رجحان ففي هذه الصورة يمتنع حصول اعتقاد الرجحان
وإن عنيتم بهذا الأخذ العزم على الإتيان بمقتضاها فذاك العزم إما أن يكون عزما جزما بحيث يتصل بالفعل لا محالة أو لا يكون كذلك
فإن كان الأول كان الفعل في ذلك الوقت واجب الوقوع فيمتنع ورود الإباحة والحظر لأنه يكون ذلك إذنا في إيقاع
ما يجب وقوعه أو منعا عن إيقاع إيقاع ما يجب وقوعه
وإن كان الثاني وهو أن يكون العزم عزما فاترا فهاهنا يجوز له الرجوع لأنه إذا عزم عزما فاترا على الترك فلو أراد الرجوع عن هذا العزم وقصد الإقدام على الفعل جاز له ذلك فعلمنا أن ما قالوه فاسد
قوله هذه الدلالة لا تطرد عند تعارض أمارتى الوجوب والحظر قلنا لا قائل بالفرق
وأيضا فالإباحة منافية للوجوب والحظر فعند تعادل أمارتي الوجوب والحظر لو حصلت الإباحة لكان ذلك قولا بتساقطهما وإثباتا لحكم لم يدل عليه دليل أصلا
قوله لم لا يجوز أن يكون في التساقط حكمة خفية
قلنا لأن المقصود من وضع الأمارة أن يتوسل بها إلى المدلول فإذا كان هو في ذاته بحيث يمتنع التوسل به إلى الحكم كان خاليا عن المقصود الأصلي منه ولا معنى للعبث إلا ذلك
وهذا بخلاف وقوع التعارض في أفكارنا لأن الرجحان
لما كان حاصلا في نفس الأمر لم يكن واضعه عابثا بل غايته أنا لقصورنا أو تقصيرنا ما انتفعنا به
أما إذا كان الرجحان مفقودا في نفس الأمر كان الواضع عابثا
وأما القسم الثاني وهو تعادل الأمارتين في فعلين متنافيين والحكم واحد
فهذا جائز ومقتضاه التخييروالدليل على جوازه وقوعه في صور
إحداها قوله عليه الصلاة و السلام في زكاة الإبل في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فمن ملك مائتين فقد ملك أربع خمسينات وخمس أربعينات فإن أخرج
الحقاق فقد أدى الواجب إذ عمل بقوله في كل خمسين حقة
وإن أخرج بنات اللبون فقد عمل بقوله عليه الصلاة و السلام في كل أربعين بنت لبون وليس أحد اللفظين أولى من الآخر فيتخير
وثانيها من دخل الكعبة فله أن يستقبل أي جانب شاء لأنه كيف فعل فهو مستقبل شيئا من الكعبة
وثالثها أن الولى إذا لم يجد من اللبن إلا ما يسد رمق أحد رضيعيه ولو قسمه عليهما أو منعهما لماتا ولو سقى أحدهما مات الآخر فهاهنا هو مخير بين أن يسقى هذا فيهلك ذاك أو ذاك
فيهلك هذا ولا سبيل إلا التخيير
ورابعها أن ثبوت الحكم في الفعلين المتنافيين نفس إيجاب الضدين وذلك يقتضى اجياب إيجاب فعل كل واحد منهما بدلا عن الآخر
واحتج الخصم على فساد التخيير بأن أمارة وجوب كل واحد من الفعلين اقتضت وجوبه على وجه لا يسوغ الإخلال به والتخيير بينه وبين ضده يسوغ الإخلال به فالقول بالتخيير مخالف لمقتضى الأمارتين معا
والجواب أما أمارة وجوب الفعل فتقتضى وجوبه قطعا
وأما المنع من الإخلال به على كل حال فموقوف على عدم الدلالة على قيام غيره مقامه وإذا كان كذلك لم يكن
التخيير مخالفا لمقتضى الأمارتين
فرع هذا التعادل إن وقع للإنسان في عمل نفسه كان حكمه فيه التخيير
وإن وقع للمفتى كان حكمه أن يخير المستفتى في العمل بأيهما شاء كما يلزمه ذلك في أمر نفسه
وإن وقع للحاكم وجب عليه التعيين لأن الحاكم نصب لقطع الخصومات فلو خير الخصمين لم تنقطع خصومتهما لأن كل واحد منهما يختار الذي هو أوفق له وليس كذلك حال المفتى
فإن قلت فهل للحاكم أن يقضى في الحكومة بحكم إحدى الأمارتين إذا كان قد قضى فيها من قبل بالأمارة الأخرى
قلت لا يمتنع ذلك عقلا كمن يجوز لمن استوى عنده جهتا القبلة أن يصلى مرة إلى جهة ومرة إلى جهة أخرى
إلا أنه منع منه دليل شرعي وهو ما روى أنه عليه الصلاة و السلام قال لأبي بكرة رضى الله عنه لا تقضين في شيء واحد بحكمين مختلفين
فأما ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قضى في المسألة الحمارية بحكمين وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي فيجوز أن يكون ذلك ليس لتعادل الأمارت بل لأنه ظن في المرة الأولى قوة تلك الأمارة وفي المرة الثانية قوة هذه الأمارة
المسألة الثانية
إذا نقل عن المجتهد قولان فإما أن يوجد له في المسألة قولان في موضع واحد أو في موضعينفإن وجد القولان في موضعين بأن يقول في كتاب بتحريم شيء وفي كتاب آخر بتحليله فإما أن يعلم التاريخ أو لا يعلم
فإن علم التاريخ فالثاني منهما رجوع عن الأول ظاهرا
وإن لم يعلم التاريخ حكى عنه القولان ولا يحكم عليه بالرجوع إلى أحدهما بعينه
وإن وجد القولان في الموضع الواحد بأن يقول في المسألة قولان فإما أن يقول عقيب هذا القول ما يشعر بتقوية أحدهما فيكون ذلك قولا له لأن قول المجتهد ليس إلا ما ترجح عنده
وإن لم يقل ذلك فهاهنا من الناس من قال انه يقتضى التخيير إلا أنا أبطلنا ذلك
وأيضا فبتقدير صحته يكون له في المسألة قول واحد وهو التخيير لا قولان بل الحق أن ذلك يدل على أنه كان متوقفا
في المسألة ولم يظهر له وجه رجحان والمتوقف في المسألة لا يكون له فيها قول واحد فضلا عن القولين
أما إذا لم يعرف قوله في المسألة وعرف قوله في نظيرها فهل يجعل قوله في نظيرها قولا له فيها فنقول إن كان بين المسألتين فرق يجوز أن يذهب إليه ذاهب لم يحكم بأن قوله في المسألة كقوله في نظيرها لجواز أن يكون قد ذهب إلى الفرق
وإن لم يكن بينهما فرق ألبتة فالظاهر أن قوله في إحدى المسألتين قول له في الأخرى
وأما الأقوال المختلفة عن الشافعى رضى الله عنه فهي على وجوه
أحدها أن يكون قد ذكر في كتبه القديمة شيئا وفي كتبه الجديدة شيئا آخر والناس نقلوهما دفعة واحدة وجعلوهما قولين له فالمتأخر كالناسخ للمتقدم
وهذا النوع من التصرف يدل على علو شأنه في العلم والدين
أما في العلم فلأنه يعرف به أنه كان طول عمره مشتغلا بالطلب والبحث والتدبر
وأما في الدين فلأنه يدل على أنه متى لاح له في الدين شيء أظهره فإنه ما كان يتعصب لنصرة قوله وترويج مذهبه بل كان منتهى مطلبه إرشاد الخلق إلى سبيل الحق
وثانيها أن يكون قد ذكر القولين في موضع واحد ونص على الترجيح كقوله في بعض ما ذكر فيه قولين وبهذا أقول وهذا أولى وبالحق أشبه
وأيضا فقد يفرع على أحدهما ويترك التفريع على الآخر فيعلم أن الذي فرع عليه أقوى عنده
وأيضا فربما نبه في آخر كلامه على الترجيح لكن المطالع قد لا يتبع كلامه
إلى آخره وقد يمل فلا ينتبه لموضع الترجيح
وثالثها أن يقول في هذه المسألة قولان ولا ينبه على الترجيح ألبتة فهاهنا احتمالان
أحدهما أنه قال في هذه المسألة قولان ولم يقل لي فيها قولان فيمكن أن يكونا قولين لبعض الناس وإنما ذكرها لينبه الناظر في كتابه على مأخذهما وإيضاح القول فيما لكل واحد منهما وعليهما
ولأنه لو لم يذكرهما فربما خطر ببال إنسان وجه في قوته إلا أنه لا يمكنه القول به لظنه أنه قول حادث خارق للإجماع فإذا نقله عرف أن المصير إليه ليس خرقا للإجماع ثم جاء الناقل فجعلهما قولين للشافعى
فهذا لا يكون عيبا على الشافعى بل على الناقل فإن الشافعى لم يقل لي فيها قولان بل قال فيها قولان فإذا جزم الراوى بكونهما قولين للشافعى كان العيب على الناقل
وثانيهما لعل مراد الشافعى بقوله فيها قولان أن في
المسألة احتمالين يمكن أن يقول بهما قائل وذلك إذا كان ما سوى ذينك القولين ظاهر البطلان
فأما ذانك القولان فيكونان قويين بحيث يمكن نصرة كل واحد منهما بوجوه جلية ظاهرة ولا يقدر على تمييز الحق منهما عن الباطل إلا البالغ في التحقيق فلا جرم أفردهما بالذكر دون سائر الوجوه
وكما أنه يجوز أن يقال للخمر التي في الدن إنها مسكرة وللسكين التي لم تقطع إنها قاطعة والمراد منه الصلاحية لا الوقوع فكذلك هاهنا
ثم إنه لم يرجح أحدهما على الآخر لأنه لم يظهر له فيه وجه الترجيح
ونقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن الشيخ أبي حامد الاسفرايينى أنه قال لم يصح عن الشافعي رضى الله عنه قولان على هذا الوجه إلا في سبع عشرة مسألة
أقول وهذا أيضا يدل على كمال منصبه في العلم والدين
أما العلم فلأن كل من كان أغوص نظرا وأدق فكرا وأكثر إحاطة بالأصول والفروع وأتم وقوفا على شرائط الأدلة كانت الإشكالات عنده أكثر
أما المصر على الوجه الواحد طول عمره في المباحث الظنية بحيث لا يتردد فيه فذاك لا يكون إلا من جمود الطبع وقلة الفطنة وكلال القريحة وعدم الوقوف على شرائط الأدلة والاعتراضات
وأما الدين فمن وجهين
الأول انه لما لم يظهر له فيه وجه الرجحان لم يستح من الاعتراف بعدم العلم ولم يشتغل بالترويج والمداهنة بل صرح بعجزه عما هو عاجز فيه وذلك لا يصدر إلا عن الدين المتين
كيف وقد نقل عن عمر رضى الله عنه اعترافه بعدم العلم في كثير من المسائل وجميع المسلمين عدوا ذلك من
مناقبه وفضائله فكيف جعلوه عيبا هاهنا
والثاني وهو أنه رضى الله عنه لم يقل ابتداءا إنى لا اعرف هذه المسألة بل وجد المسألة واقعة بين أصلين فذكر وجه وقوعها بينهما وكيفية اشتباهها بهما ثم طا لم يظهر له الرجحان تركها على تلك الحالة ليكون ذلك بعثا له على الفكر بعد ذلك وحثا لغيره من المجتهدين على طلب الترجيح
وهذا هو اللائق بالدين المتين والعقل الرصين والعلم الكامل بل من أنصف واعترف بالحق علم أن ذلك مما يدل على رجحان حاله على حال سائر المجتهدين في العلم والدين
القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل
المسألة الأولى
الترجيح تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخروإنما قلنا طريقين لأنه لا يصح الترجيح بين أمرين إلا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريق
المسألة الثانية
الأكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيحوأنكره بعضهم وقال عند التعارض يلزم التخيير أو التوقف
لنا وجوه
الأول إجماع الصحابة على العمل بالترجيح فإنهم قدموا خبر عائشة رضى الله عنها في التقاء الختانين على قول من روى انما الماء من الماء
وخبر من روت من أزواجه أنه كان يصبح جنبا على ما روى أبو هريرة أنه من أصبح جنبا فلا صوم له
وقوى على خبر أبي بكر فلم يحلفه وحلف غيره وقوى أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة
وقوى عمر خبر أبي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد الخدري
الثاني أن الظنين إذا تعارضا ثم ترجح أحدهما على الآخر كان
العمل بالراجح متعينا عرفا فيجب شرعا لقوله عليه الصلاة و السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
الثالث أنه لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح وترجيح المرجوح على الراجح ممتنع في بدائه العقول
واحتج المنكر بأمرين
الأول أن الترجيح لو اعتبر من الأمارات لاعتبر في البينات في الحكومات لأنه لو اعتبر لكانت العلة في اعتباره ترجيح الأظهر على الظاهر وهذا المعنى قائم هاهناالثاني أن إيماء قوله تعالى فاعتبروا وقوله عليه
الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر يقتضي إلغاء زيادة الظن
والجواب عن الأول والثاني أن ما ذكرته دليل ظنى وما ذكرناه قطعى والظنى
لا يعارض القطعىالمسألة الثالثة
الترجيح لا يجرى في الأدلة اليقينية لوجهين
الأول أن شرط الدليل اليقيني أن يكون مركبا من مقدمات ضرورية أو لازما عنها لزوما ضروريا إما بواسطة واحدة أو بوسائط شأن كل واحد منها ذلك
وهذا لا يتأتى إلا عند اجتماع علوم أربعة
أحدها العلم الضرورى بحقيقة المقدمات إما ابتداءا أو استنادا
وثانيها العلم الضرورى بصحة تركيبها
وثالثها العلم الضرورى بلزوم النتيجة عنها
ورابعها العلم الضرورى بأن ما يلزم عن الضرورى لزوما ضروريا فهو ضرورى
فهذه العلوم الأربعة يستحيل حصولها في النقيضين معا وإلا لزم القدح في الضروريات وهو سفسطة وإذا استحال ثبوتها امتنع التعارض
الثاني أن الترجيح عبارة عن التقوية والعلم اليقينى لا يقبل التقوية لأنه إن قارنه احتمال النقيض ولو على ابعد الوجوه كان ظنا لا علما وإن لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية
المسألة الرابعة
أشتهر في الألسنة أن العقليات لا يجرى الترجيح فيهاوهذا فيه تفصيل فإنا إن لم نكلف العوام بتحصيل العلم بالمعتقدات بل قنعنا منهم بالاعتقاد الجازم على سبيل التقليد لم يمتنع تطرق التقوية إليه
المسألة الخامسة
مذهب الشافعى رضى الله عنه حصول الترجيح بكثرة الأدلة وقال بعضهم لا يحصل
ومن صور المسألة ترجيح أحد الخبرين على الآخر لكثرة الرواة
لنا وجهان
الأول أن الأمارات متى كانت أكثر كان الظن أقوى ومتى كان الظن أقوى تعين العمل به
بيان الأول من وجوه
أحدها أن الرواة إذا بلغوا في الكثرة حدا حصل العلم بقولهم وكلما كانت المقاربة إلى ذلك الحد أكثر وجب أن يكون اعتقاد صدقهم أقوى
وثانيها أن قول كل واحد منهم يفيد قدرا من الظن فإذا اجتمعوا استحال أن لا يحصل إلا ذلك القدر الذي كان حاصلا بقول الواحد وإلا فقد اجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان
وهو محال فإذن لا بد من الزيادة
وثالثها أن احتراز العدد عن تعمد الكذب أكثر من احتراز الواحد وكذا احتمال الغلط والنسيان على العدد أبعد
ورابعها أن احتراز العاقل عن كذب يعرف اطلاع غيره عليه أكثر من احترازه عن كذب لا يشعر به غيره
وخامسها أنا إذا فرضنا دليلين متعارضين يتساويان في القوة في ذهننا فإذا وجد دليل أخر يساوى أحدهما فمجموعهما لابد وأن يكون زائدا على ذلك الآخر لأن مجموعهما أعظم من كل واحد منهما وكل واحد منهما مساو لذلك الآخر والأعظم من المساوى أعظم
وسادسها إجتماع الصحابة على أن الظن الحاصل بقول الاثنين أقوى من الظن الحاصل بقوا الواحد فإن الصديق لم يعمل
بخبر المغيرة في مسألة الجدة حتى شهد له محمد بن مسلمة
وعمر لم يقبل خبر أبي موسى حتى شهد له أبو سعيد الخدرى فلولا أن لكثرة الرواة أثرا في قوة الظن وإلا لما كان كذلك
فثبت بهذه الوجوه أن الظن إذا كان أقوى وجب أن يتعين العمل به وذلك لأنا أجمعنا على جواز الترجيح بقوة الدليل وجواز الترجيح الدليل إنما كان لزيادة القوة في أحد الجانبين وهذا المعنى حاصل في الترجيح بكثرة الأدلة
بلى إذا كان الترجيح بالقوة حصلت الزيادة مع المزيد عليه ولا فرق إلا أن في الترجيح بالقوة وجدت الزيادة مع المزيد عليه وفي الترجيح بالكثرة حصلت الزيادة في محل
والمزيد عليه في محل آخر والعلم الضرورى حاصل بأنه لا أثر لذلك
الوجه الثاني في المسألة أن مخالفة كل دليل خلاف الأصل فإذا وجد في أحد الجانبين دليلان وفي الجانب الآخر دليل واحد كانت مخالفة الدليلين أكثر محذورا من مخالفة الدليل الواحد فاشترك الجانبان في قدر من المحذور واختص أحدهما بقدر زائد لم يوجد في الطرف الآخر ولو لم يحصل الترجيح لكان ذلك التزاما لذلك القدر الزائد من المحذور من غير معارض وأنه غير جائز
واحتج الخصم بالخبر والقياس
أما الخبر فقوله عليه الصلاة السلام نحن نحكم بالظاهر فهذا بإيماءه يدل على أن المعتبر أصل الظهور وأن الزيادة عليه ملغاة ترك العمل به في الترجيح بقوة الدليل لأن هناك الزيادة مع المزيد عليه حاصلان في محل والقوى حال اجتماعها تكون أقوى منها حال تفرقها
بخلاف الترجيح بكثرة الدليل فإن هناك الزيادة في محل والمزيد عليه في محل آخر فلا يحصل كمال القوة
أما القياس فقد أجمعنا على أنه لا يحصل الترجيح بالكثرة في الشهادة والفتوى فكذا هاهنا
وأيضا أجمعنا على أن الخبر الواحد لو عارضه ألف قياس فإنه يكون راجحا على الكل وذلك يدل على أن الترجيح لا يحصل بكثرة الأدلة
والجواب عن الأول
أن ذلك الإيماء ترك العمل به في الترجيح بالقوة فوجب أن يترك العمل به في الترجيح بالكثرة لأن المعتبر قوة الظن وهى حاصلة في الموضعين
أما قوله إن في الترجيح بالقوة تحصل الزيادة مع المزيد في محل واحد وللإجتماع أثر
قلت نحن نعلم أنه وإن كان محل الزيادة مغايرا الأصل لكن مجموعهما مؤثر في تقوية الظن فإنه إذا أخبرنا مخبر عدل عن واقعة حصل ظن ما فإذا أخبرنا ثان صار ذلك الظن أقوى وإذا أخبرنا ثالث صار ذلك الظن أقوى ولا تزال القوة تزداد بازدياد المخبرين حتى ينتهي إلى العلم فعلمنا أن ما ذكروه من الفرق لا يقدح في كونه مقويا للظن
وأما فصل الشهادة فعند مالك رحمه الله يحصل الترجيح فيها بكثرة الشهود
والفرق أن الدليل يأبى اعتبار الشهادة حجة لما فيه من توهم الكذب والخطأ وتنفيذ قول شخص على شخص مثله إلا أنا اعتبرناها فصلا للخصومات فوجب أن تعتبر حجة على وجه
لا يفضى إلى تطويل الخصومات لئلا يعود على موضوعه بالنقض فلو أجرينا فيه الترجيح بكثرة العدد لزم تطويل الخصومة فإنهما إذا أقاما الشهادة من الجانبين على السوية كان لأحدهما أن يستمهل القاضي ليأتى بعدد آخر من الشهود فإذا أمهله من إقامتها بعد انقضاء المدة كان للاخر أن يفعل ذلك ويفضى ذلك إلى أن لا تنقطع الخصومة ألبتة فأسقط الشرع اعتبار الترجيح بالكثرة دفعا لهذا المحذور
وأما الترجيح بكثرة المفتين فقد جوزه بعض العلماء
وأما قوله الخبر الواحد يقدم على القياسات الكثيرة
قلنا إن كانت أصول تلك القياسات شيئا واحدا فالخبر الواحد يقدم عليها وذلك لأن تلك القياسات لا تتغاير إلا إذا عللنا حكم الأصل في كل قياس بعلة أخرى والجميع بين كلها
محال لما عرفت أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين وإذا علمنا أن الحق منها ليس إلا الواحد لم تحصل هناك كثرة الأدلة
أما إن كان أصول تلك القياسات كثيرة فلا نسلم أنه لا يحصل الترجيح
المسألة السادسة
إذا تعارض الدليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه دون أولى من العمل بأحدهما دون الثاني لأن دلالة اللفظ على جزء مفهومه دلالة تابعة لدلالته على كل مفهومه ودلالته على كل مفهومه دلالة أصليةفإذا عملنا بكل واحدة منهما بوجه دون وجه فقد تركنا العمل بالدلالة التبعية
وإذا عملنا بأحدهما دون الثاني فقد تركنا العمل بالدلالة الأصلية ولا شك أن الأول أولى
فثبت أن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما من كل وجه دون الثاني
إذا ظهر ذلك فنقول العمل بكل واحد من وجه ثلاثة أنواع
أحدها الاشتراك والتوزيع إن كان قبل التعارض يقبل ذلك
وثانيها أن يقتضى كل واحد منهما حكما ما فيعمل بكل واحد منهما في حق بعض الأحكام
وثالثها العامان إذا تعارضا يعمل بكل واحد منهما في بعض الصور كقوله عليه الصلاة و السلام ألا أخبركم بخير الشهداء قيل بلى يا رسول الله قال أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد
وقوله عليه الصلاة و السلام ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد فيعمل بالأول من حقوق الله والثاني في حقوق العباد
المسألة السابعة
إذا تعارض دليلان فإما أن يكونا عامين أو خاضيبن أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه وعلى التقديرات الأربعة فإما أن يكونا معلومين أو مظنونين أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا
وعلى التقديرات كلها فإما أن يكون المتقدم معلوما والمتأخر معلوما
أو لا يكون واحد منهما معلوما
فلنذكر أحكام هذه الأقسام
القسم الأول أن يكون حامين فإما أن يكونا معلومين أو مظنونين أو أحدهما
معلوما والآخر مظنوناالنوع الأول أن يكونا معلومين
فإما أن يكون التاريخ معلوما أو لا يكون
فإن كان معلوما فإما أن يكون المدلول قابلا للنسخ أو لا يكون
فإن قبله جعلنا المتأخر ناسخا للمتقدم سواء كانا آيتين أو خبرين أو أحدهما آية والآخر خبرا متواترا
فإن قلت فما قول الشافعى هاهنا مع أن مذهبه أن القرآن لا ينسخ بالخبر المتواتر ولا بالعكس
قلت هذا التقسيم لا يفيد إلا أنه لو وقع لكان المتأخر ناسخا للمتقدم والشافعى يقول لم يقع ذلك فليس بين مقتضى هذا التقسيم وبين قول الشافعى منافاة
وإن كان مدلولهما غير قابل للنسخ فيتساقطان ويجب الرجوع إلى دليل آخر
هذا إذا علم تقدم أحدهما على الآخر
فإما إذا علم أنهما تقارنا فإن أمكن التخيير فيهما تعين القول به فإنه إذا تعذر الجمع لم يبق إلا التخيير
ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد لما عرفت أن المعلوم لا يقبل الترجيح
ولا يجوز الترجيح بما يرجع إلى الحكم أيضا نحو كون
أحدهما حاظرا أو مثبتا حكما شرعيا لأنه يقتضى طرح المعلوم بالكلية وإنه غير جائز
وأما إذا لم يعلم التاريخ فهاهنا يجب الرجوع إلى غيرهما لأنا نجوز في كل واحد منهما أن يكون هو المتأخر فيكون ناسخا للآخر
النوع الثاني أن يكونا مظنونين فإن نقل تقدم أحدهما على الآخر كان المتأخر ناسخا
وإن نقلت المقارنة أو لم يعلم شيء من ذلك وجب الرجوع إلى الترجيح فيعمل بالأقوى
وإن تساويا كان التعبد فيهما التخيير
النوع الثالث أن يكون أحدهما معلوما والآخر مظنونا
فإما أن ينقل تقدم أحدهما على الآخر أو لا ينقل ذلك فإن نقل وكان المعلوم هو المتأخر كان ناسخا للمتقدم
وإن كان المظنون هو المتأخر لم ينسخ المعلوم
وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر وجب العمل بالمعلوم لأنه إن كان هو المتأخر كان ناسخا
وإن كان هو المتقدم لم ينسخه المظنون
وإن كان مقارنا كان المعلوم راجحا عليه لكونه معلوما
القسم الثاني من الأقسام الأربعة أن يكونا خاصين والتفصيل فيه كما في
العامين من غير تفاوتالقسم الثالث أن يكون كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه
كما في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله إلا ما ملكت أيمانكم
وكما في قوله عليه الصلاة و السلام من نام عن صلاة أو
نسيها فليصلها إذا ذكرها مع نهيه عليه الصلاة و السلام عن الصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة فإن الأول عام في الأوقات خاص في صلاة القضاء والثاني عام في الصلاة خاص في الأوقات
فهذان العمومان إما أن يعلم تقدم أحدهما على صاحبه أو لا يعلم
فإن علم وكانا معلومين أو مظنونين أو كان المتقدم مظنونا والمتأخر معلوما كان المتأخر ناسخا للمتقدم على قول من قال العام ينسخ الخاص المتقدم لأنه إذا كان عندهم أن العام
المتأخر ينسخ الخاص المتقدم فما لم يثبت كونه أعم من اللفظ المتقدم أولى بأن يكون ناسخا
وإن كان المتقدم معلوما والمتأخر مظنونا لم يجز عندهم أن ينسخ الثاني الأول ووجب الرجوع فيهما إلى الترجيح
فأما من يقول إن العام المتأخر يبنى على الخاص المتقدم والخاص المتأخر يخرج بعض ما دخل تحت العام المتقدم فاللائق بمذهبه أن لا يقول في شيء من هذه الأقسام بالنسخ بل يذهب إلى الترجيح لأنه ليس يتخلص كون المتأخر أخص من المتقدم حتى يخرج من المتقدم ما دخل تحت المتأخر
وأما إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر فإن كانا معلومين لم يجز ترجيح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد لكن يجوز الترجيح بما يتضمنه أحدهما من كونه حاظرا أو مثبتا حكما شرعيا لأن الحكم بذلك طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح أحدهما على الآخر اطراح الآخر بخلاف ما إذا تعارضا من كل وجه فإن لم يترجح أحدهما على الآخر فالحكم التخيير
وأما إذا كانا مظنونين جاز ترجيح كل واحد منهما على الآخر
بقوة الإسناد وبما تضمنه الحكم
وإذا لم يترجح فالحكم التخيير
وأما إن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا جاز ترجيح المعلوم على المظنون لكونه معلوما
فإن ترجح المظنون عليه بما يتضمن الحكم حتى حصل التعارض فإن الحكم ما قدمناه
القسم الرابع إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا
فإن كانا معلومين أو مظنونين وكان الخاص متأخرا كان ناسخا للعام المتقدموإن كان العام متأخرا كان ناسخا للخاص المتقدم عند الحنفية
وعندنا أنه يبنى العام على الخاص وإن وردا معا خص العام بالخاص إجماعا
وإن جهل التاريخ فعندنا يبنى العام على الخاص
وعند الحنفية يتوقف فيه
وأما إن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا فقد اتفقوا على تقديم المعلوم على المظنون إلا إذا كان المعلوم عاما والمظنون خاصا ووردا معا وذلك مثل تخصيص الكتاب والخبر المتواتر بخبر الواحد والقياس وقد ذكرنا أقوال الناس فيهما في باب العموم
القسم الثالث في تراجيح الأخبار
ترجيح الخبر إما أن يكون بكيفية إسناده أو بوقت وروده أو بلفظه أو بحكمه أو بأمر خارج عن ذلك
القول في التراجيح الحاصلة في الإسناد
واعلم أن الترجيح إما أن يقع بكثرة الرواة أو بأحوالهمأما الواقع بكثرة الرواة فمن وجهين
أحدهما أن الخبر الذي رواته أكثر راجح على الذي لا يكون كذلك وقد تقدم بيانه
الثاني أن يكون أحدهما أعلى إسنادا فإنه مهما كانت الرواة أقل كان احتمال الكذب والغلط أقل ومهما كان ذلك أقل كان احتمال الصحة أظهر وإذا كان أظهر وجب العمل به
فعلو الإسناد راجح من هذا الوجه لكنه مرجوح من وجه آخر وهو كونه نادرا
وأما التراجيح الحاصلة بأحوال الرواة فهى إما العلم أو الورع أو الذكاء أو الشهرة أو زمان الرواية أو كيفية الرواية
أما التراجيح الحاصلة بالعلم فهى على وجوه
أحدها أن رواية الفقيه راجحة على رواية غير الفقيه
وقال قوم هذا الترجيح إنما يعتبر في خبرين مرويين بالمعنى أما المروى باللفظ فلا
والحق أنه يقع به الترجيح مطلقا لأن الفقيه يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فإن حضر المجلس وسمع كلاما لا يجوز إجراؤه على ظاهره بحث عنه وسأل عن مقدمته وسبب وروده فحينئذ يطلع على الأمر الذي يزول به الإشكال
أما من لم يكن عالما فإنه لا يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فينقل القدر الذي سمعه وربما يكون ذلك القدر وحده سببا للضلال
وثانيها إذا كان أحدهما أفقه من الآخر كانت رواية الأفقه راجحة لأن الوثوق بإحتراز الأفقه عن ذلك الاحتمال المذكور أتم من الوثوق باحتراز الأضعف منه
وثالثها إذا كان أحدهما عالما بالعربية كانت روايته راجحة على من لا يكون كذلك لأن الواقف على اللسان يمكنه من التحفظ من مواضع الزلل مالا يقدر عليه غير العالم به
ويمكن أن يقال بل هو مرجوح لأن الواقف على اللسان يعتمد على معرفته فلا يبالغ في الحفظ اعتمادا على خاطره والجاهل باللسان يكون خائفا فيبالغ في الحفظ
ورابعها رواية الأعلم بالعربية راجحة على رواية العالم بها والوجه ما تقدم في الأفقه
وخامسها أن يكون أحدهما صاحب الواقعة فيما يروى فيكون خبره راجحا ولهذا أوجبنا الغسل بالتقاء الختانين بحديث عائشة رضى الله عنها في ذلك ورجحناه على رواية غيرها عن النبي صلى الله عليه و سلم الماء من الماء لأن عائشة كانت أشد علما بذلك
ورجح الشافعي رواية أبي رافع على رواية ابن عباس في تزويج ميمونة لأن أبا رافع كان السفير في ذلك فكان أعرف بالقصة
وسادسها رواية من مجالسته للعلماء أكثر أرجح
وسابعها رواية من مجالسته للمحدثين أكثر أرجح
وثامنها أن يكون طريق إحدى الروايتين أقوى وذلك إذا روى ما يقل اللبس كما إذا روى أنه شاهد زيدا ببغداد وقت السحر والآخر يروى أنه شاهده وقت الظهر بالبصرة فطريق هذا أظهر والاشتباه على الأول أكثر
أما التراجيح الحاصلة بالورع فهى على وجوه
أحدها رواية من ظهرت عدالته بالاختبار راجحة على رواية مستور الحال عند من يقبلها
وثانيها رواية من عرفت عدالته بالاختبار أولى من رواية من عرفت عدالته بالتزكية إذ ليس الخبر كالمعاينة
وثالثها رواية من عرفت عدالته بتزكية جمع كثير أولى من رواية من عرفت عدالته بتزكية جمع قليل
ورابعها رواية من عرفت عدالته بتزكية من كان أكثر بحثا في أحوال الناس واطلاعا عليها أولى من رواية من عرفت عدالته بتزكية من لم يكن كذلك
وخامسها رواية من عرفت عدالته بتزكية الأعلم الأروع أولى من رواية من عرفت عدالته بتزكية العالم الورع
وسادسها رواية من عرفت عدالته بتزكية المعدل مع ذكر أسباب العدالة أولى من رواية من زكاة المعدل بدون ذكر أسباب العلة العدالة
وسابعها المزكى إذا زكى الراوى فإن عمل بخبره كانت روايته راجحة على ما إذا زكاه وروى خبره
وثامنها رواية العدل الذي لا يكون صاحب البدعة أولى من رواية العدل المبتدع سواء كانت تلك البدعة كفرا في التأويل أو لم تكن
أما التراجيح الحاصلة بسبب الذكاء فهى على وجوه
أحدها رواية الأكثر تيقظا والأقل نسيانا راجحة على رواية من لا يكون كذلكوثانيها إذا كان أحدهما أشد ضبطا لكنه أكثر نسيانا والآخر يكون
أضعف ضبطا لكنه أقل نسيانا ولم تكن قلة الضبط وكثرة النسيان بحيث تمنع من قبول خبره على ما بينا في باب الأخبار فالأقرب التعارض
وثالثها أن يكون أحدهما أقوى حفظا لألفاظ الرسول صلى الله عليه و سلم من غيره فإن الحجة بالحقيقة ليست إلا في كلام الرسول عليه الصلاة و السلام
ورابعها أن يجزم أحدهما ويقول الآخر كذا قال فيما أظن
وخامسها أن يكون الرواى قد اختلط عقله في بعض الأوقات ثم لا يعرف أنه روى هذا الخبر حال سلامة العقل أو حال اختلاطه
وسادسها إذا كان أحدهما حفظ لفظ الحديث والآخر عول على المكتوب فالأول أولى لأنه أبعد عن الشبهة وفيه احتمال
أما التراجيح الحاصلة بسبب شهرة الراوى فأمور
أحدها أن يكون من كبار الصحابة لأن دينه لما منعه عن الكذب فكذا منصبه العالى يمنعه عنه ولذلك كان على رضي الله عنه يحلف الرواة وكان يقبل رواية الصديق من غير التحليفوثانيها صاحب الاسمين مرجوح بالنسبة إلى صاحب الاسم الواحد
وثالثها رواية معروف النسب راجحة على رواية مجهول النسب
ورابعها أن يكون في رواة أحد الخبرين رجال تلتبس أسماؤهم بأسماء قوم ضعفاء ويصعب التمييز فيرجح عليه الخبر الذي لا يكون كذلك
أما التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية فأمور
أحدها إذا كان قد اتفق لأحدهما رواية الحديث في زمان الصبا وغير زمان الصبا فروايته مرجوحة بالنسبة إلى رواية من لم يرو إلا في زمان البلوغوثانيها إذا كان أحدهما قد تحمل الحديث في الزمانين ولم يرو إلا في حالة البلوغ فهو مرجوح بالنسبة إلى من لم يتحمل ولم يرو إلا في الكبر
وثالثها من احتمل فيه هذان الوجهان كان مرجوحا بالنسبة إلى من
لم يوجد ذلك فيه
أما التراجيح العائدة إلى كيفية الرواية فأمور
أحدها أن يقع الخلاف في أحدهما أنه موقوف على الراوى أو مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه و سلم فالمتفق على كونه مرفوعا أولىوثانيها أن يكون أحد الخبرين منسوبا إليه قولا والآخر اجتهادا بأن يروى أنه وقع ذلك في مجلس الرسول صلى الله عليه و سلم فلم ينكر عليه فالأول أولى لأنه أقل احتمالا
وثالثها أن يذكر أحدهما سبب نزول ذلك الحكم ولم يذكره الآخر فيكون الأول راجحا لأنه يدل على أنه كان له من الاهتام بمعرفة ذلك الحكم ما لم يكن للآخر
ورابعها أن يروى أحدهما الخبر بلفظه والآخر بمعناه أو يحتمل أن يكون قد رواه بمعناه فالأول أولى
وخامسها أن يروى أحدهما حديثا يعضد الحديث الأول فيترجح على ما لا يكون كذلك
وسادسها إذا أنكر راوى الأصل فقد ذكرنا فيه تفصيلا وكيف كان فهو مرجوح بالنسبة إلى ما لا يكون كذلك
وسابعها لو قبلنا المرسل فإذا أرسل أحدهما وأسند الآخر فعندنا المسند أولى
وقال عيسى بن أبان المرسل أولى
وقال القاضي عبد الجبار يستويان
لنا أنه إذا أرسل فعدالته معلومة لرجل واحد وهو الذي يروى عنه وإذا أسند صارت عدالته معلومة للكل لأنه يكون كل واحد متمكنا من البحث عن أسباب جرحه وعدالته ولا شك أن من لم تظهر عدالته إلا لرجل واحد يكون مرجوحا بالنسبة إلى من ظهرت عدالته لكل أحد لاحتمال أن يكون قد خفي حال الرجل على إنسان واحد ولكن يبعد أن يخفي حاله على الكل فثبت أن المسند أولى
احتج المخالفون بأمرين
الأول أن الثقة لا يقول قال الرسول ذلك فيحكم عليه بالتحليل والتحريم ويشهد به إلا وهو قاطع أو كالقاطع بذلك بخلاف ما إذا أسند الحديث وذكر الواسطة فإنه لم يحكم على ذلك الخبر بالصحة فلم يزد على حكاية أن فلانا زعم أن الرسول عليه الصلاة و السلام قال ذلك فكان الأول أقوى الثاني روى أن الحسن قال إذا حدثني أربعة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بحديث تركتهم وقلت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبر عن نفسه أنه لا يستجيز هذا الإطلاق إلا عند فرط الوثوق
والجواب عن الأول أن قول الراوى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يمكن إجراؤه على ظاهره لأنه يقتضى الجزم بصحة خبر الواحد وهو جهل وغير جائز فوجب حمله على أن المراد منه أني أظن أن رسول لله صلى الله عليه و سلم قال وإذا كان كذلك كان الإسناد أولى من الإرسال لأن في الإسناد يحصل ظن العدالة للكل وفي الإرسال لا يحصل ذلك الظن إلا للواحد
وهذا هو الجواب بعينه عن الوجه الثاني
فرعان
الأول لو صح رجحان المرسل على المسند فإنما يصح لو قال الراوى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما إذا لم يقل ذلك بل قال عن النبي صلى الله عليه و سلم فالأظهر أنه لا يترجح لأنه في معنى قوله روى عن الرسولالثاني رجح قوم بالحرية والذكورة قياسا على الشهادة وفيه احتمال
القول في التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر وهي ثمانية
الأول أن تكون إحدى الآيتين أو الخبر مدنيا والآخر مكيا فالمدني مقدم لأن الغالب في المكيات ما كان قبل الهجرة والمدني لا محالة مقدم عليه أما المكيات المتأخرة عن المدنيات فقليلة والقليل ملحق بالكثير فيحصل الرجحان
الثاني الخبر الذي يظهر وروده بعد قوة الرسول عليه الصلاة و السلام وعلو شأنه راجح على الخبر الذي لا يدل على ذلك لأن علو شأنه كان في آخر أمره صلى الله عليه و سلم فالخبر الوارد في هذا الوقت حصل فيه ما يقتضى تأخره عن الأول
والأولى أن يفصل فيقال إن دل الأول على علو الشأن والثاني على الضعف ظهر تقديم الأول على الثاني
أما إذا لم يدل الثاني لا على القوة ولا على الضعف فمن أين يجب تقديم الأول عليه
الثالث أن يكون راوى أحد الخبرين متأخر الإسلام ويعلم أن سماعه كان بعد إسلامه وراوى الخبر الثاني متقدم الإسلام فيقدم الأول لأنه أظهر تأخرا
والأولى أن يفصل فيقال المتقدم إذا كان موجودا مع المتأخر لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر
وأما إذا علمنا أنه مات المتقدم قبل إسلام المتأخر أو علمنا أن أكثر رويات المتقدم متقدم على رواية المتأخر فهاهنا نحكم بالرجحان لأن النادر يحلق يلحق بالغالب
الرابع أن يحصل إسلام الراويين معا كإسلام خالد وعمرو بن العاص لكن يعلم أن سماع أحدهما بعد إسلامه ولا يعلم ذلك في سماع الآخر فيقدم الأول لأنه أظهر تأخرا
الخامس أن يكون أحد الخبرين مؤرخا بتاريخ محقق والآخر يكون خاليا من التاريخ فيقدم الأول لأنه أظهر تأخرا
مثاله ما روى أنه عليه الصلاة و السلام في مرضه الذي توفي فيه خرج فصلى بالناس قاعدا والناس قيام
فهذا يقتضى جواز اقتداء القائم بالقاعد
وقد روى أنه عليه الصلاة و السلام قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعين وهذا يقتضي عدم جواز ذلك فرجحنا الأول لأنه كان في آخر أحوال النبي عليه الصلاة و السلام وأما الثاني فيحتمل انه كان قبل المرض
السادس أن يكون أحدهما مؤقتا بموقت متقدم والآخر يكون
خاليا عن الوقت فيقدم الخالى لأنه أشبه بالمتأخر
السابع أن تكون حادثة كان الرسول صلى الله عليه و سلم يغلظ بها زجرا لهم عن العادات القديمة ثم خفف فيها نوع تخفيف فيرجح التخفيف على التغليظ لأنه أظهر تأخرا
وهذا ضعيف لاحتمال أن يقال بل يرجح التغليظ على التخفيف لأنه عليه الصلاة و السلام ما كان يغلظ إلا عند علو شأنه وذلك متأخر
الثامن عمومان متعارضان أحدهما واردا ابتداءا والآخر على سبب فالأول أولى لأن من الناس من قال الوارد على السبب يختص به ولا يعم لكن ذلك وأن لم يجب فلا أقل من أن يفيد الترجيح
واعلم أن هذه الوجوه في التراجيح ضعيفة وهى لا تفيد إلا خيالا ضعيفا في الرجحان
القول في التراجيح الراجعة إلى اللفظ
وهى من وجوهالأول أن يكون اللفظ في أحدهما بعيدا عن الاستعمال وفيه ركاكة والآخر فصيح
فمن الناس من رد الأول لأنه عليه الصلاة و السلام كان أفصح العرب فلا يكون ذلك كلاما له
ومنهم من قبله وحمله على أن الراوى رواه بلفظ نفسه
وكيف ما كان فأجمعوا على ترجيح الفصيح عليه
وثانيها قال بعضهم يقدم الأفصح على الفصيح
وهو ضعيف لأن الفصيح لا يجب في كل كلامه أن يكون كذلك
وثالثها أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا فيقدم الخاص على العام
وقد تقدم دليله في باب العموم
ورابعها أن يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا فتقدم الحقيقة لأن دلالتها أظهر
وهذا ضعيف لأن المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقة فإنك لو قلت فلان بحر فهو أقوى دلالة على قولك فلان سخى
وخامسها أن يكونا حقيقتين إلا أن أحدهما أظهر في المعنى إما لكثرة ناقليه أو لكون ناقله أقوى وأتقن من ناقل غيره ويجرى هاهنا كل ما ذكرناه في ترجيح الخبر نظرا إلى حال الراوى
وسادسها
أن يكون وضع أحدهما لمسماه متفقا عليه ووضع الآخر مختلفا فيه
وسابعها أن الذي يكون محتاجا إلى الإضمار مرجوح بالنسبة إلى الذي لا يحتاج إليه
وثامنها الذي يدل على المقصود بالوضع الشرعي أو العرفي أولى مما يدل عليه بالوضع اللغوي
وهاهنا تفصيل فإن اللفظ الذي صار شرعيا حمله على المعنى الشرعي أولى من حمله على اللغوي
فأما الذي لم يثبت ذلك فيه مثل أن يدل أحد اللفظين بوضعه الشرعي على حكم واللفظ الثاني بوضعه اللغوي على حكم وليس للشرع في هذا اللفظ اللغوى عرف شرعي فلا نسلم ترجيح الشرعي على هذا اللغوى لأن هذا اللغوى إذا لم ينقله الشرع فهو لغوى عرفي شرعي
وأما الثاني فهو شرعي وليس بلغوى ولا عرفي والنقل على خلاف الأصل فكان اللغوى أولى
وتاسعها
إذا تعارض مجازان فالذي يكون أكثر شبها بالحقيقة أولى
وأيضا إذا تعارض خبران ولا يمكن العمل بأحدهما إلا بمجازين والآخر يمكن العمل به بمجاز واحد كان هذا راجحا على الأول لأنه أقل مخالفة للأصل
وعاشرها أن يكون أحدهما دخله التخصيص والآخر لم يدخله التخصيص فالذي لم يدخله التخصيص يقدم على الأول لأن الذي دخله التخصيص قد أزيل عن تمام مسماه والحقيقة مقدمة على المجاز
وحادى عشرها
أن يدل أحدهما على المراد من وجهين والآخر من وجه واحد يقدم الأول لأن الظن الحاصل منه أقوى
وثاني عشرها أن يكون أحد الحكمين مذكورا مع علته والآخر ليس كذلك فالأول أقوى
ومن هذا القبيل أن يكون أحدهما مقرونا بمعنى مناسب والآخر يكون معلقا بمجرد الاسم فيكون الأول أولى
وثالث عشرها أن يكون أحدهما تنصيصا على الحكم مع اعتباره بمحل آخر والآخر ليس كذلك يقدم الأول في المشبه والمشبه به جميعا لأن اعتبار محل بمحل إشارة إلى وجود علة جامعة
مثاله قول الحنفية في قوله عليه الصلاة و السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر كالخمر تخلل فتحل رجحناه في المشبه على قوله عليه الصلاة و السلام لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
وفي المشبه به في مسألة تحليل الخمر على قوله أرقها
ورابع عشرها أن تكون دلالة أحدهما مؤكدة ودلالة الأخرى لا تكون مؤكدة فتقدم الأولى كقوله عليه الصلاة و السلام فنكاحها باطل باطل باطل
وخامس عشرها أن يكون أحدهما تنصيصا على الحكم مع ذكر المقتضي لضده
كقوله عليه الصلاة و السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها يقدم على ما ليس كذلك لأن اللفظ يدل على ترجيح ذلك على ضده ولأن تقديمه يقتضى النسخ مرة وتقديم ضده يقتضى النسخ مرتين فيكون الأول أولى
وسادس عشرها يقدم أن يكون أحد الدليلين مقرونا بنوع تهديد فإنه على ما لا يكون كذلك كقوله عليه الصلاة و السلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم وكذا القول لو كان التهديد في أحدهما أكثر
وسابع عشرها أن يكون أحد الدليلين يقتضى الحكم بواسطة والآخر يقتضيه
بغير واسطة فالثاني يرجح على الأول كما إذا كانت المسألة ذات صورتين فالمعلل إذا فرض الكلام في صورة وأقام الدليل عليه فالمعترض إذا أقام الدليل على خلافه في الصورة الثانية ثم توسل إلى الصورة الأخرى بواسطة الإجماع فيقول المعلل دليلي راجح على دليلك لأن دليلى بغير واسطة ودليلك بواسطة فيكون الترجيح معى لأن كثرة الوسائط الظنية تقتضي كثرة الاحتمالات فيكون مرجوحا بالنسبة إلى ما يقل الاحتمال فيه
وثامن عشرها المنطوق مقدم على المفهوم إذا جعلنا المفهوم حجة لأن المنطوق أقوى دلالة على الحكم من المفهوم
القول في التراجيح الراجعة إلى الحكم وهى من وجوه خمسة
الأول إذا كان أحد الخبرين مقررا لحكم الأصل والثاني يكون ناقلا فالحق أنه يجب ترجيح المقرروقال الجمهور من الأصوليين إنه يجب ترجيح الناقل
لنا أن حمل الحديث على ما لا يستفاد إلا من الشرع أولى من حمله على ما يستقل العقل بمعرفته فلو جعلنا المبقي مقدما على الناقل لكان واردا حيث لا يحتاج إليه لأنا في ذلك الوقت نعرف ذلك الحكم بالعقل فلو قلنا إن المبقى ورد بعد الناقل لكان واردا حيث يحتاج إليه فكان الحكم بتأخره عن الناقل أولى من الحكم بتقدمه عليه
وأحتج الجمهور على قولهم بوجهين
الأول أن اعتبار الناقل أولى لأنه يستفاد منه ما لا يعلم إلا منه
وأما المبقى فإن حكمه معلوم بالعقل فكان الناقل أولى
الثاني أن في القول بكون الناقل متأخرا تقليل النسخ لأنه يقتضى إزالة حكم العقل فقط وفي القول يكون المقرر متأخرا تكثير
النسخ لأن الناقل أزال حكم العقل ثم المقرر أزال حكم الناقل مرة أخرى
والجواب عن الأول
ما ذكرناه في الدليل وهو أنا لو جعلنا المبقى متأخرا لكنا قد استفدنا منه مالا يستقبل العقل به ولو جعلناه متقدما لكنا قد استفدنا منه ما يتمكن العقل من معرفتهوعن الثاني أن ورود الناقل بعد ثبوت حكم الأصل ليس بنسخ لأن دلالة العقل مقيدة بشرط عدم دليل السمع فإذا وجد فلا يبقى دليل العقل فلا يكون دليل السمع مزيلا لحكم العقل بل مبينا لانتهائه فلا يكون ذلك خلاف الأصل
وأيضا فما ذكرتموه معارض بوجه آخر وهو أنا لو جعلنا المبقى مقدما لكان المنسوخ حكما ثابتا بدليلين دليل العقل ودليل الخبر فيكون هذا أشد مخالفة لأنه يكون ذلك نسخا للأقوى بالأضعف وهو غير جائز
وأما على الوجه الذي قلناه فلا يكون المنسوخ إلا دليلا واحدا
فرع فان قيل أفتجعلون العمل بالناقل على ما ذكره الجمهور أو بالمقرر على ما ذكرتموه في باب الترجيح
قلنا قال القاضي عبد الجبار إنه ليس من باب الترجيح واستدل عليه بوجهين
الأول أنا نعمل بالناقل على أنه ناسخ والعمل بالناسخ ليس من باب الترجيح
الثاني أنه لو كان العمل بالناقل ترجيحا لوجب أن يعمل بالخبر الآخر لولاه لأن هذا حكم كل خبرين رجحنا أحدهما على الآخر
ومعلوم أنه لولا الخبر الناقل لكنا إنما نحكم بموجب الخبر الآخر لدلالة العقل لا لأجل الخبر
ويمكن أن يجاب عن الأول
بأنا لا نقطع في الأصول بأن الناقل عن حكم الأصل متأخر وناسخ وإنما نقول الظاهر ذلك مع جواز خلافه فهو إذن داخل في باب الأولى وهذا ترجيحوعن الثاني أنه لو كان الخبر الناقل لعلمنا بموجب الخبر الآخر لأجله ألا ترى أنا نجعله حكما شرعيا ولهذا لا يصح رفعه إلا يصح النسخ به ولولا أنه بعد ورود الخبر صار شرعيا وإلا لما كان كذلك
الثاني قال القاضي عبد الجبار الخبران إذا كان أحدهما نفيا والآخر إثباتا وكانا شرعيين فإنهما سواء وضرب لذلك أمثلة ثلاثة
أحدها أن يقتضى العقل حظر الفعل ثم ورد خبران في إباحته ووجوبه
وثانيها أن يقتضى العقل وجوب الفعل ثم ورد خبران في حظره وإباحته
وثالثها أن يقتضى العقل إباحة الفعل ثم ورد خبران في وجوبه وحظره
واعلم أن هذا لا يستقيم على مذهبنا في أن العقل لا يستقل في شيء من الأحكام بالقضاء والنفى بالإثبات بل ذلك لا يستفاد إلا من الشرع
وحينئذ لا يكون لأحدهما مزية على الآخر
وأما على مذهب المعتزلة فلا يتم ذلك لأنه لا بد في كل نفى وإثبات متواردين على حكم واحد أن يكون أحدهما عقليا
بيانه أن الإباحة تشارك الوجوب في جواز الفعل وتخالفه
في جواز الترك وتشارك الحظر في جواز الترك وتخالفه في جواز الفعل فهى تشارك كل واحد من الوجوب والحظر بما به تخالف الآخر
إذا ثبت هذا فنقول إذا اقتضى العقل الحظر فقد اقتضى جواز الترك أيضا لأن ما صدق عليه أنه محظور فقد صدق عليه أنه يجوز تركه فإذا جاء خبر الإباحة والوجوب فالإباحة إنما تنافي الوجوب من حيث إن الإباحة تقتضى جواز الترك لا من حيث إنها تقتضى جواز الفعل لكن جواز الفعل هاهنا كما عرفت حكم عقلى فثبت أنه لا بد هاهنا في النفي والإثبات من كون أحدهما عقليا فيه فليعمل فيه كما في المثال الأول
وأما المثال الثاني وهو ما إذا اقتضى العقل الوجوب وجاء خبران في الحظر والإباحة فالكلام فيه كما في المثال الأول
وأما المثال الثالث وهو ما إذا اقتضى العقل والإباحةثم جاء خبر أن في الحضر والوجوب فنقول لما ثبت أن الإباحة
تشارك كل واحد من الوجوب والحظر بما به تخالف الآخر وإذا كانت الإباحة مقتضى العقل لزم أن يكون الوجوب مقررا لحكم العقل من وجه وناقلا من وجه آخر
وكذا القول في الحظر فهاهنا أيضا لابد في النفى والإثبات المتواردين على أمر واحد أن يكون أحدهما عقليا
وإذا ثبت أنه لا بد في النفى والإثبات من كون أحدهما عقليا رجع الترجيح إلى ما تقدم من أن الناقل أرجح أم المبقى
فرع إذا كان مقتضى العقل الحظر ثم ورد خبران في الإباحة والوجوب والإباحة تشارك الحظر من وجه وتخالفه من وجه آخر فخبر الإباحة يقتضى بقاء حكم العقل من وجه والنقل من وجه
وأما الوجوب فإنه يخالف الحظر في القيدين معا فيكون الوجوب مقتضيا للنقل من وجهين
فمن رجح الخبر الناقل على المبقى رجح خبر الوجوب ومن رجح المبقى على الناقل فبالعكس
وكذا القول فيما إذا اقتضى العقل الوجوب وجاء خبران في الحظر والإباحة
فأما إذا اقتضى العقل الإباحة وجاء خبران في الحظر والوجوب فكل واحد منهما يشارك الإباحة من وجه ويخالفها من وجه آخر فإذن كل واحد منهما ناقل من وجه ومبق من وجه آخر فيحصل التساوى ولا يحصل الترجيح
الثالث إذا تعارض خبران في الحظر والإباحة وكانا شرعيين فقال أبو هاشم وعيسى بن أبان إنهما يستويان
وقال الكرخى وطائفة من الفقهاء خبر الحظر راجح
احتجوا على الترجيح للحظر بالخبر والحكم والمعنى
أما الخبر فقوله عليه الصلاة و السلام ما اجتمع الحلال
والحرام إلا وغلب الحرام الحلال ضعيف ومنقطع
وقال عليه الصلاة و السلام دع ما يريبك إلى مالا يريبك وجواز هذا الفعل يريبه لأنه بين أن يكون حراما وبين أن يكون مباحا فما يريبه جواز فعله فيجب تركه
وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى
وأما الحكم فإنه من طلق أحد نسائه ونسيها حرم عليه وطء جميع نسائه وكذلك لو أعتق إحدى إمائه
وأما المعنى فهو أنه دار بين أن يرتكب الحرام أو يترك المباح وترك المباح أولى فكان الترجيح للمحرم احتياطا
فإن قلت ولا يمتنع أيضا أن يكون مباحا فيكون باعتقاده الحظر مقدما على مالا يأمن كونه جهلا
قلت إنه إذا استباح المحظور فقد أقدم على محظورين أحدهما الفعل والثاني اعتقاد إباحه وليس كذلك إذا امتنع من المباح لاعتقاد حظره لأنه محظور واحد والغرض هو الترجيح بضرب من القوة
الرابع المثبت للطلاق والعتاق يقدم على النافي لهما عند الكرخى
وقال قوم يسوى بينهما
وجه الأول أن ملك النكاح واليمين مشروع على خلاف الأصل فيكون زوالهما على وفق الأصل والخبر المتأيد بموافقة الأصل راجح على الواقع على خلاف الأصل
الخامس النافي للحد مقدم على المثبت له عند بعض الفقهاء
وأنكره المتكلمون
وجه الأول من وجوه
أحدها أن الحد ضرر فتكون شرعيته على خلاف الأصل والنافي له على وفق الأصل فيكون النافي له راجحا
وثانيها أن ورود الخبر في نفى الحد إن لم يوجب الجزم بذلك النفى فلا أقل من أن يفيد شبهة فيه إذا حصلت الشبهة سقطت الحدود لقوله عليه الصلاة و السلام ادرؤا الحدود بالشبهات
وثالثها إذا كان الحد يسقط بتعارض البينتين مع ثبوته في أصل الشرع فلأن يسقط بتعارض الخبرين في الجملة ولم يتقدم له ثبوت أولى
القول في الترجيحات الحاصلة بالأمور الخارجة وهي من وجوه
أحدها الترجيح بكثرة الأدلة وقد سبق القول فيهوثانيها أن يقول بعض أئمة الصحابة أو يعمل بخلافه والخبر لا يجوز خفاؤه عليه
وهذا عند البعض يحمل على نسخه أو أنه لا أصل له إذا لولاه لما خالف
وعند الشافعى رضى الله عنه لا يحمل على ذلك لكن إذا عارضه خبر لا يكون كذلك كان راجحا عليه
وثالثها إذا عمل بأحدهما أكثر السلف ممن لا يجب تقليدهم
قال عيسى بن أبان يجب ترجيحه لأن الأكثر يوفقون للصواب مالا يوفق له الأقل
وقال آخرون لا يحصل الترجيح لأنه لا يجب تقليدهم
ورابعها أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى يكون مرجوحا إما لاختلاف المجتهدين في قبوله أو لأن كونه مما تعم به البلوى إن لم يوجب القدح فيه فلا أقل من إفادته المرجوحية
واعلم أن بعض ما يرجح به الخبر قد يكون أقوى من بعض فينبغى إذا استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح أن تعتبر الكيفية
فإن كان أحد الجانبين أقوى كيفية وجب العمل به
وإن كان أحد الجانبين أكثر كمية وأقل كيفية والجانب الآخر على العكس منه وجب على المجتهد أن يقابل ما في أحد الجانبين بما في الجانب الآخر ويعتبر حال قوة الظن
والكلام في قوة كثير من وجوه الترجيحات طريقة الاجتهاد
القسم الرابع في تراجبح الأقيسة
وهي إما أن تكون بحسب ماهية العلة أو بحسب ما يدل على وجودها أو بحسب ما يدل على عليتها أو بحسب ما يدل على ثبوت الحكم في الأصل أو بحسب محل ذلك الحكم أو بحسب محالها أو بحسب أمور منفصلة عن ذلكالنوع الأول في التراجيح المعتبرة بحسب ماهية العلة فنقول إنا بينا أن الحكم الشرعي إما أن يكون معللا بالوصف الحقيقي أو بالحكمة أو بالحاجة أو بالوصف العدمي أو بالوصف الإضافي أو بالوصف التقديرى أو بالحكم الشرعي
وعلى كل التقديرات فالعلة إما أن تكون مفردة أو مركبة من قيدين أو أكثر
واعتمد بعضهم في التراجيح الواقعة في هذا الباب على أمرين
أحدهما أن كل ما كان أشبه بالعلل العقلية فهو راجح على ما لا يكون كذلك لأن العقل أصل النقل والفرع كلما كان أشبه بالأصل كان أقوى
وثانيها أن كل ما كان متفقا عليه فهو أولى مما يكون مختلفا فيه وكل ما كان الخلاف فيه أقل فهو راجح على ما يكون الخلاف فيه أكثر والسبب فيه أن وقوع الخلاف فيه يدل على حصول الشك والشبهة
وهذان المأخذان ضعيفان جدا إلا في شيء واحد وهو أن كل ما كان متفقا عليه فهو أولى مما يكون مختلفا فيه وذلك لأن المقدمة إذا كانت مجمعا عليها كانت يقينية والقياس الذي يكون بعض مقدماته يقينيا وبعضه ظنيا أقوى من الذي
يكون كل مقدماته ظنيا لأن الاحتمال في الأول أقل مما في الثاني ومتى كان الاحتمال أقل كان الظن أقوى
إذا عرفت هذا الأصل فلنرجع إلى التفصيل وفيه مباحث
أحدها أن التعليل بالوصف الحقيقي أولى من التعليل بسائر الأقسام لأن جواز التعليل بالوصف الحقيقي مجمع عليه بين القائسين والتعليل بسائر الأقسام مختلف فيه فيكون القياس الذي يكون الحكم في أصله معللا بالوصف الحقيى أقوى مما لا يكون كذلك
وثانيها التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالعدم وبالوصف الإضافي وبالحكم الشرعي وبالوصف التقديري
أما أنه أولى من العدم فلأن العلم بالعدم لا يدعو إلى شرع الحكم إلا إذا حصل العلم بإشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة فيكون الداعى إلى شرع الحكم في الحقيقة هو المصلحة لا العدم وإذا
كانت العلة هى المصلحة لا العدم كان التعليل بالمصلحة أولى من التعليل بالعدم
فإن قلت فهذا يقتضى أن يكون التعليل بالمصلحة أولى من التعليل بالوصف
قلت كان الواجب ذلك إلا أن الوصف أدخل في الضبط من الحاجة فلهذا المعنى ترجح الوصف على المصلحة والعدم المطلق لا يتقيد إلا إذا أضيف إلى الوجود فهو في نفسه غير مضبوط فالعدم ليس بمؤثر في الحقيقة وليس بضابط في نفسه فظهر الفرق
وإذا ثبت أن التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالعدم وقد ثبت أن الإضافات ليست أمورا وجودية لزم أن يكون التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالإضافات
وأما أنه أولى من الحكم بالشرع والوصف التقديرى فلأن التعليل بالحاجة تعليل بنفس المؤثر وهذا يمنع من التعليل بغيره ترك العمل به في الوصف الحقيقي بالإجماع ولأنه اشتبه بالعلل العقلية فيبقى في هذه الصورة على الأصل
وثالثتها التعليل بالعدم أولى أم بالحكم الشرعي
يحتمل أن يقال العدم أولى لأنه أشبه بالأمور الحقيقية ويحتمل أن يقال بل بالحكم الشرعي أولى لأنه أشبه بالوجود
ورابعها التعليل بالعدم أولى أم بالصفات التقديرية
والأشبه هو الأول لأن المقدر معدوم أعطى حكم الموجود فكل ما في المعدوم من المحذورات فهو حاصل في المقدر مع مزيد محذور آخر وهو أنه كونه معدوما أعطى حكم الموجود فكان المعدوم أولى
وخامسها تعليل الحكم الوجودى بالعلة الوجودية أولى من تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي ومن تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودى
والحكم الوجودى بالوصف العدمي لأن كون العلة والمعلول عدميين يستدعى تقدير كونهما وجوديين لأنا بينا أن العلة والمعلول وصفان ثبوتيان فحملهما على المعدوم لا يمكن إلا إذا قدر المعدوم موجودا وتعليل العدم بالعدم أولى من القسمين الباقيين للمشابهة
وأما أن تعليل العدم بالوجود أولى أم تعليل الوجود بالعدم ففيه نظر
وسادسها التعليل بالحكم الشرعي أولى من التعليل بالوصف المقدر لأن الأول على وفق الأصل والثاني على خلاف الأصل
وسابعها التعليل بالعلة المفردة أولى من التعليل بالعلة المركبة لأن الاحتمال في المفردة أقل مما في المركب لأن المفرد لو وجد لوجد بتمامه ولو عدم لعدم بتمامه
وأما المركب فليس كذلك لأن المركب من قيدين فقط يحتمل في جانب الوجود احتمالات ثلاثة وهي أن يوجد
الجزء بدلا عن ذاك وذاك بدلا عن هذا ويوجد المجموع
وكذا القول في جانب العدم المركب من قيود ثلاثة يوجد فيه احتمالات سبعة في طرف الوجود وسبعة في طرف العدم ومعلوم أن ما كان الاحتمال فيه أقل كان أولى
فهذه جملة التراجيح العائدة إلى ماهية العلة
النوع الثاني القول في التراجيح العائدة إلى ما يدل على أن ذات العلة
موجودةاعلم أن العلم بوجود تلك الذوات إما أن يكون بديهيا أو حسيا أو استدلاليا
والاستدلال إما أن يفيد العلم أو الظن
وعلى التقديرين فذلك الدليل إما أن يكون عقليا محضا أو نقليا محضا أو مركبا منهما
فلنتكلم في هذه الأقسام فنقول
أما إذا كان الطريق مفيدا لليقين سواء كان بديهيا أو
حسيا أو استدلاليا يقينيا وسواء كان عقليا محضا أو نقليا محضا أو مركبا منهما وسواء كثرت المقدمات أو قلت فإنه لا يقبل الترجيح
وكلام أبي الحسين يدل على أنه يقبل
أما أن القطعيات لا تقبل الترجيح فلما تقدم
فإن قلت الضرورى أولى من النظرى لأن الضرورى لا يقبل الشك والشبهة والنظرى يقبل ذلك
قلت النظرى واجب الحصول عند حصول جميع مقدماته المنتجة له كما أن البديهي واجب الحصول عند حصول تصور طرفيه
وكما أن النظرى يزول عند زوال أحد الأمور التي لا بد منها في حصول جميع مقدماته المنتجة له فكذلك الضرورى يزول عند زوال أحد التصورات التي لا بد منها
فإذن لا فرق في وجود الجزم عند حضور موجباته في البابين بل الفرق هو أن النظرى يتوقف على أمور أكثر مما
يتوقف عليه الضرورى فلا جرم كان زوال النظرى أكثر من زوال الضرورى
فأما وجوب الوجود وامتناع العدم عند حصول كل ما لا بد منه فلا فرق بين الضرورى والنظرى فيه ألبتة
أما إذا كان الطريق الدال على وجود العلة ظنيا فقد قيل كلما كانت المقدمات المنتجة لذلك الظن أقل كان القياس أقوى لأن المقدمات متى كانت أقل كان احتمال الخطأ أقل ومتى كان احتمال الخطأ أقل كان ظن الصواب أقوى
واعلم أن هذا الكلام على عمومه ليس بحق لأن الظن يقبل التفاوت في القوة والضعف فإذا فرضنا دليلا كانت مقدماته قليلة إلا أن كل واحدة منها كانت مظنونة ظنا ضعيفا ودليلا آخر ظنيا معارضا للأول مقدماته كثيرة إلا أن كل واحدة منها كانت مظنونة ظنا قويا فالقوة الحاصلة في أحد الجانبين بسبب قلة الكمية قد تصير معارضة من الجانب الآخر بسبب قوة الكيفية وقد تكون قوة الكيفية في أحد الجانبين أزيد من قلة الكمية في الجانب الآخر حتى أن الدليل الظنى الذي يكون مركبا من مائة
مقدمة قد يفيد ظنا أقوى من الظن الحاصل من الدليل المركب من مقدمتين
فإذن لا بد من اعتبار هذا التفصيل الذي ذكرناه
إذا عرفت هذا فنقول الدليل الظني الذي يدل على وجود العلة إما أن يكون نصا أو إجماعا أو قياسا
أما القياس فالكلام فيه كما في الأول ولا يتسلسل بل ينتهي إلى النص أو الإجماع
أما النص فطرق الترجيح فيه ما تقدم في القسم الثالث من هذا الكتاب
وأما الإجماع فإن كانا قطعيين لم يقبل الترجيح
وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا لم يقبل الترجيح لأن الإجماع المعلوم مقدم على المظنون
أما إذا كانا مظنونين فهذا يقع على وجهين
أحدهما الإجماعان المختلف فيهما عند المجتهدين كالإجماع الذي يحدث عن قول البعض وسكوت الباقين
وثانيهما الإجماع المنقول بطريق الآحاد
فهذان القسمان في محل الترجيح
وأما الذي يقال إن أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه فإن أريد به عدم الاختلاف في أحدهما ووقوعه في الآخر فذلك ليس من باب الترجيح لأن تقدم المعلوم على المظنون قطعي
وإن عني به قله الاختلاف في أحدهما وكثرته في الآخر فلا نسلم أن هذا القدر يوجب الترجيح
ولنختم هذا الفصل بشيء وهو أنه إذا تعارض قياسان وكان وجود الأمر الذي جعل علة لحكم الأصل في أحد القياسين معلوما وفي الآخر مظنونا كان الأول راجحا لما بينا أن القياس الذي بعض مقدماته معلوم راجح على ما كان كل مقدماته مظنونا
النوع الثالث القول في التراجيح الحاصلة بسبب الطرق الدالة على علية
الوصف في الأصلوقد ذكرنا في كتاب القياس أن الطرق الدالة على علية الوصف
في الأصل إما الدليل النقلى أو العقلى
أما الدليل النقلى فإما أن يكون نصا أو إيماءا
أما النص فقد يكون بحيث لا يحتمل غير العلية وهو ألفاظ ثلاثة وهى قوله لعله كذا أو لسبب كذا كذا أو لأجل كذا فهذا مقدم على جميع الطرق النقلية
وأما الذي يحتمل غير العلية ولكنه ظاهر جدا فألفاظ ثلاثة وهي اللام وإن والباء وحرف اللام مقدم على إن والباء لأن اللام ظاهر جدا في التعليل وأما لفظ أن فقد يكون للتأكيد ولفظ الباء قد يكون للإلصاق كقولك كتبت بالقلم وقد يفيد كونه محكوما به كقوله عليه الصلاة و السلام أنا أقضي بالظاهر
أما حيث تأتي لا للآلة ولا لأن تكون محكوما به كان مرادفا للأم فإنه لا فرق بين أن يقال قتلته لجنايته وقتلته بجنايته
وأما الباء وإن أيهما المقدم ففيه احتمال وأما الإيماءات ففيها أبحاث
أحدها أنا بينا أن دلالة الإيماء على علية الوصف في الأصل لا تتوقف على كونه مناسبا ولكن الوصف الذي يكون مناسبا راجح على مالا يكون كذلك
وثانيهما أن إيماء الدلالة اليقينية راجح على إيماء الدلالة الظنية لما عرفت أن الدليل الذي بعض مقدماته يقيني والبعض ظني راجح على ما يكون كل مقدماته ظنيا
وأما إذا ثبتت علية الوصفين بإيماء خبر الواحد فوجوه الترجيح فيه ما ذكرناه في باب الخبر الواحد
وثالثها أن الجمهور اتفقوا على أن ما ظهرت عليته بالإيماء راجح على ما ظهرت عليته بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبر
وهذا فيه نظر وذلك لأن الإيماء لما لم يوجد فيه لفظ يدل على العلية فلا بد وأن يكون الدال على عليته أمر آخر سوى اللفظ ولما بحثنا لم نجد شيئا يدل على عليتها إلا أحد أمور ثلاثة المناسبة والدوران والسبر على ما مر ذلك في باب الإيماءات
وإذا ثبت أن الإيماءات لا تدل إلا بواسطة أحد هذه الطرق الثلاثة كان الأصل لا محالة أقوى من الفرع فكان كل واحد من هذه الثلاثة أقوى من الإيماءات
ورابعها أنا قد ذكرنا أن أقسام الإيماءات خمسة وكل واحد من تلك الأقسام يندرج تحته أقسام كثيرة واستيفاء القول في هذا يقتضي أن نتكلم في تفاصيل كل واحد من أقسام تلك الأقسام مع ما يشاركه في جنسه ومع ما هو خارج من جنسه لأنه لا يبعد أن يكون أحد الجنسين أقوى من الجنس الآخر ويكون بعض أنواع الضعيف أقوى من بعض أنواع القوي لكنا تركنا هذا لطولها وكثرتها
أما الطرق العقلية فقد ذكرنا منها ستة وهي المناسب والمؤثر والشبه والدوران والطرد والسبر فلنتكلم في تفاصيل هذه الأجناس ثم في تفاصيل أنواع كل واحد من هذه الأجناس
أما تفاصيل هذه الأجناس ففيها أبحاث
أحدهاأن المناسبة أقوى من الدوران
وقال قوم الدوران أقوى وعبروا عن ذلك بأن العلة المطردة المنعكسة أقوى مما لا يكون كذلك
لنا أن الوصف إنما يؤثر في الحكم لمناسبته فالمناسبة علة لعلية العلة وليس تأثير الوصف في الحكم لدورانه معه لأن الدوران في الحقيقة ليس من لوازم العلية لأن العلة إذا كانت أخص من المعلول كانت العلية منفكة هناك عن
الدوران وقد ينفك الدوران عن العلية كما في الصور التي عددناها في باب الدوران
وإذا كان كذلك كان الاستدلال بالمناسبة على العلية أقوى من الاستدلال بالدوران عليها
احتج المخالف بوجهين
الأول أن العلة المطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية فتكون أقوىالثاني أنهم أجمعوا على صحة المطرد المنعكس
ومن الناس من أنكر العلة التي لا تكون منعكسة
والجواب عن الأول
لا نسلم أن العكس واجب في العلل العقلية وقد بيناه في كتبنا العقلية
سلمناه لكن لا نسلم أن الأشبه بالعلل العقلية أولى
وعن الثاني أن ذلك يقتضي ترجيح المناسب المطرد المنعكس على المناسب الذي لا يكون مطردا منعكسا ولا نزاع فيه
أما أنا لا نقضي بترجيح الدوران المنفك عن المناسبة على المناسب المنفك عن الدوران فلأنه إذا وجد الدوران بدون المناسبة فقد لا تحصل العلة كرائحة الخمر مع حرمتها
وثانيها أن المناسبة أقوى من التأثير لأنه لا معنى للتأثير إلا أنه عرف تأثير هذا الوصف في نوع هذا الحكم وفي جنسه وكون الشي مؤثرا في شيء لا يوجب كونه مؤثرا فيما يشاركه في جنسه
أما كونه مناسبا فهو الذي لأجله صار الوصف مؤثرا في الحكم فكان الاستدلال بالمناسبة على العلية أقوى من الاستدلال بالتأثير عليها
وثالثها أن السبر إما أن يكون قاطعا في مقدماته أو مظنونا في مقدماته أو قاطعا في بعض مقدماته ومظنونا في البعض
فإن كان قاطعا في كل مقدماته كان العمل به متعينا وليس هذا بترجيح
أما إذا كان مظنونا في كل مقدماته مثل أن يدل دليل ظني على أن الحكم معلل ودليل آخر ظني على أن العلة إما هذا الوصف أو ذاك ودليل آخر ظني على أن العلة ليست ذلك الوصف فيحصل هاهنا ظن أن العلة ليست إلا هذا الوصف فهاهنا العمل بالمناسبة أولى من العمل بهذا السبر وذلك لأن الدليل الدال على هذه المقدمات الثلاث التي لا بد منها في السبر إما النص أو الإيماء أو الطرق العقلية
فإن كان هو النص صارت تلك المقدمات يقينية وقد فرضناها ظنية هذا خلف
وإن كان إيماءا فقد عرفت أن الإيماء مرجوح بالنسبة إلى المناسبة
وأما الطرق العقلية فالمناسبة أولى من غيرها لأن المناسبة
مستقلة بإنتاج العلية والسبر لا ينتج العلية إلا بعد مقدمات كثيرة والمثبت لتلك المقدمات إما المناسبة أو غيرها
فإن كان الأول كانت المناسبة أولى من السبر لأن في إثبات الحكم بالمناسبة تكفي المناسبة الواحدة في الإنتاج وفي السبر لابد من ثلاث مقدمات والكثرة دليل المرجوحية
وإن كان الثاني كانت المناسبة أولى لأن المناسبة علة لعلية العلة وغير المناسبة ليس كذلك فالاستدلال بالمناسبة على العلية أولى
وأما إن كان السبر مظنونا في بعض المقدمات مقطوعا في البعض عاد الترجيح المذكور في تلك المقدمات المظنونة
ورابعها أن المناسبة أقوى من الشبه والطرد وذلك واضح لا حاجة به إلى الدليل
فهذا هو الكلام في تراجيح هذه الطرق الستة العقلية بحسب الجنس ولنتكلم الآن في أنواع كل واحد منها وفيه سائل
المسألة الأولى
ترجيح بعض المناسبات على بعض إما أن يكون بأمور عائدة إلى ما هياتها أو بأمور خارجة عنهاأما القسم الأول فتقريره أنك قد عرفت أن كون الوصف مناسبا إما أن يكون لأجل مصلحة دنيوية أو دينية والمصلحة الدنيوية إما أن تكون في محل الضرورة أو في محل الحاجة أو في محل الزينة والتتمة
وظاهر أن المناسبة التي من باب الضرورة راجحة على التي من باب الحاجة والتي من باب الحاجة مقدمة على التي من باب الزينة
ثم قد عرفت أن المناسبة التي من باب الضرورة خمسة وهي مصلحة النفوس والعقول والأديان والأموال والأنساب فلا بد من بيان كيفية ترجيح بعض هذه الأقسام على بعض
ثم عرفت أن الوصف المناسب للحكم قد يكون نوعه مناسبا لنوع الحكم وقد يناسب جنسه نوع الحكم وقد يناسب نوعه جنس الحكم وقد يناسب جنسه جنس الحكم
ولا شك في تقدم الأول على الثلاثة الأخيرة والثاني والثالث
وأما الثاني والثالث فهما كالمتعارضين ولا شك في تقدمهما على الرابع
ثم الجنس قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا والمناسبة المتولدة من الجنس القريب تقدم على المناسبة المتولدة من الجنس البعيد
ثم المناسبة في كل قسم من هذه الأقسام قد تكون جلية وقد تكون خفية
أما الجلي فهو الذي يلتفت الذهن إليه في أول سماع الحكم كقوله عليه الصلاة السلام لا يقضى القاضي وهو غضبان فإنه يلتفت الذهن عند سماع هذا الكلام إلى أن الغضب إنما منع من الحكم لكونه مانعا من استيفاء الفكر
وأما الخفي فهو الذي لا يكون كذلك
ولا شك في تقدم الجلي على الخفي
وأما القسم الثاني وهو ترجيح بعض المناسبات على بعض بأمور خارجة عنها
فذلك على وجوهأحدها أن المناسبة المتأيدة بسائر الطرق أعني الإيماء والدوران والسبر راجحة على ما لا يكون كذلك ويرجع حاصله إلى الترجيح بكثرة الأدلة
وثانيها المناسبة الخالية عن المعارض راجحة على ما لا يكون كذلك فإن المناسبة وإن كانت لا تبطل بالمعارضة لكنها مرجوحة بالنسبة إلى مالا تكون معارضة
وثالثها الذي يناسب الحكم من وجهين راجح على مالا يناسب إلا من وجه واحد وعلته ظاهرة
وأيضا كلما كانت الجهات أكثر كانت أرجح
مسألة
الدوران الحاصل في صورة واحدة راجح على الحاصل في صورتين لأن احتمال الخطأ في الدوران الحاصل في الصورة الواحدة أقل من احتماله في الدوران الحاصل في صورتين ومتى كان احتمال الخطأ أقل كان الظن أقوىبيان الأول أن العصير لما لم يكن مسكرا في الزمان الأول فلم يكن محرما ثم صار مسكرا بعد ذلك فصار محرما ثم لما زالت المسكرية مرة أخرى زالت الحرمة فهاهنا نقطع بأن شيئا من الصفات الباقية في الأحوال الثلاثة لا يصلح لعلية هذا الحكم وإلا لزم وجود العلة بدون الحكم
وأما الدوران في صورتين فهو كما يقول الحنفي في مسألة الحلي كونه ذهب موجب للزكاة لأن التبر لما كان ذهبا وجبت الزكاة فيه والثياب لما لم تكن ذهبا لم تجب الزكاة فيها فهاهنا لا يمكن
القدح في علية الصفات الباقية بمثل ما ذكرناه في الصورة الأولى فثبت أن احتمال المعارض في الصورة الأولى أقل فكان الظن فيها أقوى
مسألة
قد ذكرنا أن الشبه قد يكون شبها في الحكم الشرعي وقد يكون شبها في الصفة
واختلفوا في الراجح والأظهر أن الشبه في الصفة أولى لأنها أشبه بالعلل العقلية
النوع الرابع في التراجيح الحاصلة بسبب دليل الحكم
فنقول هذا الطريق لا شك أنه يكون دالا ثم ذلك الطريق إما أن يكون في القياسين المتعارضين قطعيا أو ظنيا أو يكون في أحدها قطعيا وفي الآخر ظنيا فإن كان قطعيا فيهما معا استحال الترجيح في ذلك لما عرفت
وإن كانا ظنيين فالدليل الدال عليهما إما أن يكون لفظا أو إجماعا أو قياسا فلنتكلم في تفاصيل هذه الأجناس ثم في تفاصيل أنواع كل واحد من هذه الأجناس
أما البحث الأول فيشتمل على مسألتين
إحداها قالوا القياس الذي ثبت الحكم في أصله بالإجماع أقوى من الذي ثبت الحكم في أصله بالدلائل اللفظية لأن الدلائل اللفظية تقبل التخصيص والتأويل والإجماع لا يقبلهماوهذا مشكل لأنا حيث أثبتنا الإجماع إنما أثبتناه بالدلائل اللفظية والفرع كيف يكون أقوى حالا من الأصل
المسألة الثانية
قد تقدم في كتاب القياس أن الحكم في الأصل لا يجوز أن يكون مثبتا بالقياس وإن كان قد جوزه قوموالمجوزون اتفقوا على أن القياس الذي ثبت الحكم في
أصله بالنص راجح على الذي ثبت الحكم في أصله بالقياس لأن ذلك القياس لا يتفرع على قياس آخر إلى غير نهاية بل لا بد من الانتهاء إلى أصل ثبت حكمه بالنص
وإذا كان كذلك فالنص أصل القياس والأصل راجح على الفرع
البحث الثاني في تفاصيل أنواع كل واحد من هذه الأجناس الثلاثة
فنقول أما الدلائل اللفظية فإما أن تكون متواترة أو احادافإن كانت متواترة لم يمكن ترجيح بعضها على بعض إلا بما يرجع إلى المتن
وإن كانت آحادا أمكن ترجيح بعضها على بعض بما في المتن وبما في الإسناد وتلك الوجوه قد ذكرناها فيما تقدم فلا فائدة في الإعادة
وبالجملة فكلما كان ثبوت الحكم في الأصل أقوى كان القياس أرجح
فإن كان ثبوت الحكم في أحد القياسين مقطوعا وفي الآخر كان الأول أولى لما تقدم أن القياس الذي بعض مقدماته مقطوع والبعض مظنون راجح على ما كل مقدماته مظنون
وأيضا فإذا ثبت الحكم في أحد الأصلين بإيماء خبر متواتر فهو راجح على ما ثبت بإيماء خبر واحد ولكن بشرط التعادل في الإيماءين
ولو ثبت الحكم في الأصل بخبر الواحد فالذي هو مدلول حقيقة اللفظ راجح على ما هو مدلول مجازه
النوع الخامس القول في التراجيح الحاصلة بسبب كيفية الحكم
وهي على وجوهأحدها القياس الذي يوجب حكما شرعيا راجح على ما يوجب حكما
عقليا لأن القياس دليل شرعي فيجب أن يكون حكمه شرعيا إلا أنا لو قدرنا تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي على المثبتة للحكم العقلي لزم النسخ مرتين ولو قدرنا تقديم العقل لزم النسخ مرة
فإن قلت كيف يجوز أن يستخرج من أصل عقلي علة شرعية
قلت يجوز ذلك إذا لم ينقلنا عنه الشرع فنستخرج العلة التي لأجلها لم ينقلنا عنه الشرع
أما إذا كان أحد الحكمين نفيا والآخر إثباتا وكانا شرعيين فقيل إنهما يتساويان لكنا ذكرنا في باب ترجيح الأخبار أنه لابد وأن يكون أحدهما عقليا
وثانيها الترجيح بكون أحد الحكمين في الفرع حظر فذلك الحظر إما أن يكون شرعيا أو عقليا فإن كان شرعيا فهو راجح على الإباحة لأنه شرعى ولأن الأخذ بالحظر أحوط وإن كان عقليا فكونه حظرا جهة الرجحان وكونه عقليا جهة المرجوحية فيجب الرجوع إلى ترجيح آخر ولا بد في الحظر والإباحة من كون أحدهما عقليا على ما تقدم
وثالثها أن يكون حكم إحدى العلتين العتق وحكم الأخرى الرق
فالمثبتة للعتق أولى لأن للعتق مزيد قوة ولأنه على وفق الأصل
ورابعها إذا كان حكم إحداهما في الفرع إسقاط الحد وحكم الأخرى إثباته فالمسقطة أولى لأن ثبوته على خلاف الأصل
فإن قلت المثبت للعقوبات يثبت حكما شرعيا والدارىء يثبت حكما عقليا فالمثبت للحكم الشرعي أولى
الجواب أن الشرع إذا ورد بالسقوط صار السقوط حكما شرعيا ولذلك لا يجوز نسخه إلا بما يسخ الحكم الشرعي
وخامسها الترجيح بكون أحد حكمي العلة أزيد من حكم الآخر بأن يكون حكم أحدهما الندب وحكم الآخر الإباحة فالمثبت
للندب أولى لأن في الندب معنى الإباحة وزيادة فكانت أولى إذا كانت الزيادة شرعية
وسادسها العلة إذا كان حكمها الطلاق كانت راجحة لما ثبت من قوة الطلاق
وسابعها القياس على الحكم الوارد على وفق قياس الأصول أولى من القياس على الحكم الوارد بخلاف قياس الأصول وعلته كون الأول متفقا عليه والثاني مختلفا فيه ولأن الأول خال عن المعارض والثاني مع المعارض فيكون الأول أولى
وثامنها القياس على أصل أجمع على تعليل حكمه أولى مما لا يكون كذلك وعلته أن على التقدير الأول تكون إحدى مقدمات القياس يقينية وهي كون الحكم في الأصل معللا فيكون ذلك القياس راجحا على مالا يكون شيء من مقدماته يقينيا
وتاسعها الترجيح بشهادة الأصول للحكم وقد يراد بها دلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك الحكم
وهذه وإن كانت صريحة فهي الأصل في إثبات الحكم فلا يجوز الترجيح بها وإن مسها احتمال شديد جاز ترجيح القياس بها
وعاشرها يقع الترجيح بقول الصحابي لأنه أعرف بمقاصد الرسول صلى الله عليه و سلم وكذلك إذا عضدت العلة علة أخرى
كما ترجح أخبار الآحاد بعضها ببعض
وحادي عشرها أن يلزم من ثبوت الحكم في الفرع محذور
كتخصيص عموم أو ترك العمل بظاهر أو ترجيح مجاز على حقيقة
وفرق بين هذا الترجيح وبين ما ذكرناه من شهادة الأصول لأن الحكم الشرعي قد يكون بحيث يوجد في الشرع أصول تشهد بصحته وأصول أخر تشهد ببطلانه فالقوة الحاصلة بسبب وجود الأصول التي تشهد بصحته غير القوة الحاصلة بسبب عدم ما يشهد ببطلانه
ومن هذا الباب أن يكون الحكم لازما للعلة في كل الصور فإن من يجوز تخصيص العلة يسلم أن العلة المطردة أولى من المخصوصة
النوع السادس في التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة
وهو إما الأصل أو الفرع أوأما الأصل فبأن تشهد للعلة الواحد أصول كثيرة وذلك
لأن شهادة الأصل دليل على كون تلك العلة معتبرة وكل شهادة دليل مستقل فالترجيح بالشهادات الكثيرة ترجيح بكثرة الدلائل
وأما الفرع ففيه صور
إحداها أن العلة المتعدية أولى من القاصرة عند الأكثرين خلافا لبعض الشافعيةلنا أن المتعدية أكثر فائدة ولأنها متفق عليها والقاصرة مختلف فيها فالأخذ بالمتفق عليه أولى فكانت المتعدية أولى
احتج المخالف بأن التعدية فرع الصحة والفرع لا يقوى الأصل
والجواب لكنه يدل على قوته
وثانيها إذا كانت فروع إحدى العلتين أكثر من الأخرى قال بعضهم هو أولى وقال آخرون لا يحصل به الرجحان
حجة الأولين أنها إذا كثرت فروعها كثرت فوائدها فكانت أولى
فإن قلت إنما يكون إذا كثرت فوائدها الشرعية وكثرة فروعها ترجع إلى كثرة ما خلق الله تعالى من ذلك النوع وليس ذلك بأمر شرعي
قلت كثرة وجود الفروع ليس بأمر شرعي لكن الفروع لما كثرت لزم من جعل هذا الوصف علة كثرة الأحكام فكان أولى
احتج الآخرون بوجوه
الأول لو كان اعم العلتين أولى من اخصهما لكان العمل بأعم الخطابين أولى من اخصهما الثاني التعدية فرع صحة العلة في الأصل فلو توقفت صحتها على التعدية لزم الدور
الثالث كثرة الفروع ترجع إلى كثرة ما خلق الله تعالى من ذلك النوع وليس ذلك بأمر شرعي بخلاف كثرة الأصول
والجواب عن الأول
إنما لم يكن العمل بأعم الخطابين أولى لأن فيه طرحا لأخصهما وليس كذلك العمل بأخصهما
أما العلة فإذا انتهى الأمر إلى الترجيح وترجيح إحداهما يوجب طرح الأخرى فكان طرح ما تقل فائدته أولى
وعن الثاني والثالث ما تقدم
وثالثها العلة إذا كانت مثبتة للحكم في كل الفروع فهي راجحة
على ما تثبت الحكم في بعض الفروع
وسبب الرجحان أن الدال على الحكم في كل الفروع يجري مجرى الأدلة الكثيرة لأن العلة تدل على كل واحد منها
وأيضا دلالته على ثبوت الحكم في كل واحد من تلك الفروع يقتضي ثبوته في البواقي ضرورة أن لا قائل بالفرق فهذه العلة العامة قائمة مقام الأدلة الكثيرة
وأما العلة الخاصة في الصورة الواحدة فهي دليل واحد فقط فكان الأول أولى
وأما الترجيح الراجع إلى الأصل والفرع معا فهو أن تكون العلة يرد بها الفرع إلى ما هو من جنسه والأخرى يرد بها الفرع إلى خلاف جنسه مثاله قياس الحنفية الحلي على التبر أولى من قياسه على سائر الأموال لأن الاتحاد من حيث الجنسية
ثابتة بينهما
وهذا آخر الكلام في التراجيح
الكلام في الاجتهاد
والنظر في ماهية الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه وحكم الاجتهادالركن الأول
في الاجتهاد
وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان يقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل ولا يقال استفرغ وسسعه في حمل النواةوأما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهذا سبيل مسائل الفروع ولذلك تسمى هذه المسائل مسائل
الاجتهاد والناظر فيها مجتهد وليس هذا حال الأصول
الركن الثاني
في المجتهد وفيه مسائل
مسألةقال الشافعي رضي الله عنه يجوز أن يكون في أحكام الرسول صلى الله عليه و سلم ما صدر عن الإجتهاد وهو قول أبي يوسف رحمه الله وقال أبو علي وأبو هاشم إنه لم يكن متعبدا به وقال بعضهم كان له أن يجتهد في الحروب وأما في أحكام الدين فلا وتوقف أكثر المحققين في ذلك أم المثبتون فقد احتجوا بأمور
أحدها عموم قوله تعالى فاعتبروا يا أولى الأبصار
وكان عليه الصلاة و السلام أعلى الناس بصيرة وأكثرهم إطلاعا على شرائط القياس وما يجب ويجوز فيها وذلك أن لم يرجح دخوله في هذا الأمر على دخول غيره فلا أقل من المساواة فيكون مندرجا تحت الآية فكان مأمورا بالقياس فكان فاعلا له وإلا قدح في عصمته
وثانيها أنه إذا غلب على ظنه كون الحكم في الأصل معللا بوصف ثم علم أو ظن حصول ذلك الوصف في صورة أخرى فلابد أن يظن أن حكم الله تعالى في الفرع مثل حكمه في الأصل وترجيح الراجح على المرجوح من مقتضيات بدائه العقول على ما قررناه في كتاب القياس وهذا يقتضي أن يجب عليه العمل بالقياس
وثالثها أن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص فيكون أكثر ثوابا لقوله عليه الصلاة و السلام أفضل العبادات أحمزها
أي أشقها ولو لم يعمل الرسول عليه الصلاة و السلام بالاجتهاد مع أن أمته عملوا به كانت الأمة أفضل منه في هذا الباب وإنه غير جائز فإن قلت فهذا يقتضي أن لا يعمل الرسول صلى الله عليه و سلم إلا بالاجتهاد لأن ذلك أفضل وأيضا فإنما يجب اتصافه بهذا المنصب لو لم يجد منصبا اعلى منه لكنه وجده لأنه يستدرك الأحكام وحيا وهذا المنصب أعلى من الاجتهاد
قلت الجواب عن الأول أن ذلك غير ممكن لأن العمل بالاجتهاد مشروط بالنص على أحكام الأصول وإذا كان كذلك تعذر العمل في كل الشرع بالاجتهاد
وعن الثاني أن الوحي وإن كان أعلى درجة من الاجتهاد لكن ليس فيه تحمل المشقة في استدراك الحكم ولا يظهر فيه أثر دقه الخاطر
وجودة القريحة وإذا كان هذا نوعا مفردا من الفصيلة لم يجز خلو الرسول عنه بالكلية
ورابعها قوله عليه الصلاة و السلام العلماء ورثة الأنبياء وهذا يوجب أن تثبت له درجة الاجتهاد ليرثوه عنه إذ لو ثبت لهم ذلك ابتداءا لم يكونوا وارثين عنه فإن قلت أراد به في إثبات أركان الشرع قلت إنه تقييد من غير دليل
وخامسها أن بعض السنن مضافة إلى الرسول صلى الله عليه و سلم
ولو كان الكل بالوحي لم يبق لتلك الإضافة مزيد فائدة كما أن الشافعي رضي الله عنه إذا أثبت حكما بالنص الظاهر الجلى الذى لا يفتقر فيه البتة إلى اجتهاد لا يقال أن ذلك مذهب الشافعي فلا يقال مذهب الشافعي رضي الله عنه وجوب الصلوات الخمس وأما الذي يثبته بضرب من اجتهاد فإنه يضاف إليه فكذا هاهنا
وأما الذي يدل على أنه كان مجتهدا في أمر الحروب أنه اجتهد في أخذ الفداء عن أسارى بدر
بعدما وكان راجعهم في تلك الحال وذلك لا يمكن إلا مع الاجتهاد
واحتج المانعون بأمور
أحدها قوله تعالى وما ينطق عن الهوىوثانيها أن بعض الصحابة راجعه في منزل نزله وقال إن كان هذا بوحي الله تعالى فالسمع والطاعة وإلا فليس هو بمنزل مكيدة فدل هذا على جواز مراجعته في اجتهاده ولا تجوز مراجعته في أحكام الشرع فيلزم أن لا يكون فيها ما هو باجتهاده
وثالثها أن الاجتهاد لا يفيد إلا الظن وأنه عليه الصلاة و السلام كان قادرا على تلقيه من الوحي والقادر على تحصيل العلم لا يجوز له الاكتفاء بالظن كالمعاين للقبلة لا يجوز له أن يغمض عينيه ويجتهد فيها
ورابعها أن مخالفه عليه الصلاة و السلام في الحكم يكفر لقوله تعالى فلا
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم والمخالف في هذه المسائل الشرعية لا يكفر لأن الرجل إذا أجتهد وأخطأ فيها فله أجر واحد والمستوجب للأجر لا يمكن تكفيره
وخامسها لو جاز له العمل بالاجتهاد لما توقف في شيء من الأحكام الشرعية على الوحي لأن حكم الوحي في الكل كان معلوما له وطرق الاجتهاد كانت مظنونة له فعند وقوع الواقعة التي ما أنزل عليه فيها وحي كان مأمورا بالاجتهاد فكان ينبغي أن لا يتوقف إلى نزول الوحي لكنه توقف كما في مسألة الظهار واللعان
وسادسها لو جاز له الاجتهاد لجاز لجبريل عليه السلام وحينئذ لا يعرف أن هذا الشرع الذي جاء به إلى محمد صلى الله عليه و سلم من نص الله تعالى أو من اجتهاد جبريل عليه السلام
والجواب عن الأول أن الله تعالى متى قال له مهما ظننت كذا فاعلم أن حكمي كذا فها هنا العمل بالظن عمل بالوحي لا بالهوى
وعن الثاني أنه يدل على جواز مراجعته في الآراء والحروب والأحكام خارجة عن ذلك
وعن الثالث أنا إنما نجوز الاجتهاد فيما لم يوجد فيه نص من الله
تعالى ولم يكن متمكنا من معرفة الحكم بالنص
وعن الرابع أنه لا يمتنع أن يقال الحكم وإن كان مظنونا أولا إلا أنه عليه الصلاة و السلام لما أفتى به وجب القطع به كما قلنا في الإجماع الصادر عن الاجتهاد
وعن الخامس أن العمل بالاجتهاد مشروط بالعجز عن وجدان النص فلعله عليه الصلاة السلام كان يصبر مقدار ما يعرف به أن الله تعالى لا ينزل فيه وحيا
وعن السادس أن ذلك الاحتمال مدفوع بالإجماع
مسألة
إذا جوزنا له صلى الله عليه و سلم الاجتهاد فالحق عندنا أنه لا يجوز أن يخطىء وقال قوم يجوز بشرط أن لا يقر عليهلنا
أنا مأمورون باتباعه في الحكم لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فلو جاز عليه الخطأ لكنا مأمورين بالخطأ وذلك ينافي كونه خطأواحتج المخالف بقوله تعالى عفا الله عنك لم أذنت لهم فهذا يدل على أنه أخطأ فيما أذن لهم وقال تعالى في أسارى بدر لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم فقال عليه الصلاة و السلام لو
نزل عذاب من الله لما نجا إلا ابن الخطاب وهذا يدل على أنه أخطأ في أخذ الفداء ولأنه تعالى قال قل إنما أنا بشر مثلكم فلما جاز الخطأ على من غيره
جاز أيضا عليه ولأن النبي صلى الله عليه و سلم قال إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم ألحن بحجته من غيره فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه إنما أقطع له قطعة من النار فلو لم يجز أن يقضي لأحد إلا بحقه لم يقل هذا ولأنه يجوز أن يغلط في أفعاله فيجوز أن يغلط في أقواله كغيره من المجتهدين
والجواب عن هذه الوجوه مذكور في الكتاب الذي صنفناه في عصمة الأنبياء فلا فائدة في الإعادة
مسألة
اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأما في زمان الرسول عليه الصلاة و السلام فالخوض فيه قليل الفائدة لأنه لا ثمرة له في الفقه ثم نقول المجتهد إما أن يكون بحضرة الرسول عليه الصلاة و السلام أو يكون غائبا عنه أما إن كان بحضرته فيجوز تعبده بالاجتهاد عقلا لأنه لا يمتنع أن يقول الرسول عليه الصلاة و السلام له لقد أوحي إلي بأنك مأمور بأن تجتهد أو مأمورا بأن تعمل على وفق ظنك ومنهم من أحاله عقلا
واحتج عليه بأن الاجتهاد في معرض الخطأ والنص آمن منه وسلوك السبيل المخوف مع القدرة على سلوك السبيل الآمن قبيح عقلا
وجوابه أن الشرع لما قال له أنت مأمور بأن تجتهد وتعمل على وفق ظنك كان آمنا من الغلط لأنه بعد الاجتهاد يكون آتيا بما أمر به وأما وقوع التعبد به فمنعه أبو علي وأبو هاشم وأجازه قوم بشرط الإذن وتوقف فيه الأكثرون
احتج المانعون بوجهين
الأول أن الصحابة لو اجتهدوا في عصره كما اجتهدوا بعده لنقل كما نقل اجتهادهم بعدهالثاني أن الصحابة كانت تفزع في الحوادث إلى الرسول صلى الله عليه و سلم ولو كانوا مأمورين بالاجتهاد لما فزعوا إليه
واحتج القائلون بالوقوع بأمور
الأول أنه عليه الصلاة و السلام حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم فقال عليه الصلاة و السلام لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة الثاني أنه عليه الصلاة و السلام قال لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهنى لما أمرهما أن يحكما بين خصمين إن أصبتما فلكما عشر حسنات وإن أخطأتما فلكما حسنة واحدة
الثالث أنه عليه الصلاة و السلام كان مأمورا بالمشاورة لقوله تعالى وشاورهم في الأمر ولا فائدة في ذلك إلا جواز الحكم على حسب اجتهادهم
والجواب عن الأول لعله قل اجتهادهم في حضرة الرسول صلى الله عليه و سلم فلم ينقل لقلته وأيضا فقد نقل اجتهاد سعد بن معاذ وعمرو بن العاص
وعن الثاني لعلهم فزعوا إليه فيما لم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد ولعلهم تركوه لصعوبته وسهولة وجدان النص
وعن الثالث وهو خبر سعد وعمرو أنه خبر واحد فلا يجوز التمسك به إلا في مسألة عملية وهذه المسألة لا تعلق لها بالعمل
وعن الرابع أن ذلك في الحروب ومصالح الدنيا لا في أحكام الشرع
وأما الغائب عن حضرة الرسول عليه الصلاة و السلام فلا
شك في جواز أن يتعبده الله تعالى بالاجتهاد لا سيما عند تعذر الرجوع وضيق الوقت وأما وقوع التعبد به فقال به الأكثرون والاعتماد فيه على خبر معاذ
مسألة في شرائط المجتهد
أعلم أن شرط الاجتهاد أن يكون المكلف بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام وهذه المكنة مشروطة بأمورأحدها أن يكون عارفا بمقتضى اللفظ ومعناه لأنه لو لم يكن كذلك لم يفهم منه شيئا ولما كان اللفظ قد يفيد معناه لغة وعرفا وشرعا وجب أن يعرف اللغة والألفاظ العرفية والشرعية
وثانيها أن يعرف من حال المخاطب أنه يعني باللفظ ما يقتضيه ظاهره إن تجرد أو ما يقتضيه مع قرينة إن وجدت معه قرينة لأنه لولا ذلك لما حصل الوثوق بخطابه لجواز أن يكون عنى به غير ظاهره مع أنه لم يبينه
قالت المعتزلة وذلك إنما يعرف بحكمة المتكلم أو بعصمته والحكم بحكمة الله تعالى مبني على العلم بأنه تعالى عالم بقبح القبيح وعالم بغناه عنه
وأما أصحابنا فإنهم قالوا الشيء وإن كان جائز الوقوع قطعا لكنه قد نقطع بأنه لا يقع فإنا نجوز انقلاب ماء جيحون دما وانقلاب الجدارن ذهبا وتولد الإنسان لا من الأبوين دفعة واحدة ومع ذلك نقطع بأنه لا يقع فكذا هاهنا نحن وإن جوزنا من الله تعالى كل شيء لكنه تعالى خلق فينا علما بديهيا بأنه لا يعني بهذه الألفاظ إلا ظواهرها فلذلك أمنا من وقوع التلبيس
وثالثها أن يعرف مجرد اللفظ إن كان مجردا وقرينته إن كان مع قرينة لأنا لو لم نعرف ذلك لجوزنا في المجرد أن تكون معه قرينة تصرفه عن ظاهره
ثم القرينة قد تكون عقلية وقد تكون سمعية أما القرينة العقلية فإنها تبين ما يجوز أن يراد باللفظ مما لا يجوز وأما السمعية فهي الأدلة التي تقتضي تخصيص العموم في الأعيان وهو المسمى بالتخصيص أو في الأزمان وهو النسخ والذي يقتضي تعميم الخاص وهو القياس وحينئذ يجب أن يكون عارفا بشرائط القياس ليميز ما يجوز عما لا يجوز ثم هذه الأدلة السمعية غائبة عنا فلا بد من نقلها والنقل إما تواتر أو آحاد فلا بد وأن يكون عارفا بشرائط كل واحد منهما ثم عند الإحاطة بأنواع الأدلة لابد وأن يكون عارفا بالجهات المعتبرة في التراجيح
فإن قال قائل فصلوا العلوم التي يحتاج المجتهد إليها
قلنا قال الغزالي رحمه الله مدارك الأحكام أربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل فلا بد من العلم بهذه الأربعة ولا بد معها من أربعة أخرى اثنان مقدمان واثنان مؤخران فهذه ثمانية لا بد من شرحها
أما كتاب الله تعالى فلا بد من معرفته وفيه تحقيقان
أحدهما أنه لا يشترط معرفة جميعه بل ما يتعلق منه بالأحكام وهو خمسمائة آيةوالثاني أنه لا يشترط حفظها بل أن يكون عالما بمواقعها حتى يطلب منها الآية المحتاج إليها عند الحاجة
وأما السنة فلا بد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بها الأحكام وهي مع
كثرتها مضبوطة في الكتب وفيها التحقيقان المذكوران إذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأخبار بالمواعظ وأحكام الآخرة
والثاني أنه لا يلزمه حفظها بل أن يكون عنده أصل مصحح مشتمل على الأحاديث المتعلقة بالأحكام
وأما الإجماع فينبغي أن يكون عالما بمواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلاف
الإجماع وطريق ذلك أن لا يفتي إلا بشيء يوافق قول واحد من العلماء المتقدمين أو يغلب على ظنه أنه واقعة متولدة في هذا العصر ولم يكن لأهل الإجماع فيها خوضوأما العقل فيعرف البراءة الأصلية ويعرف أنا مكلفون بالتمسك بها إلا إذا ورد ما يصرفنا عنه وهو نص أو إجماع أو قياس على شرائط الصحة فهذه هي العلوم الأربعة
وأما العلمان المقدمان
فأحدهما علم شرائط الحد والبرهان على الإطلاق
وثانيهما معرفة النحو واللغة والتصريف لأن شرعنا عربي فلا يمكن التوسل إليه إلا بفهم كلام العرب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا بد في هذه العلوم من القدر الذي يتمكن المجتهد به من معرفة الكتاب والسنة
وأما العلمان المتمان
فأحدهما يتعلق بالكتاب وهو علم الناسخ والمنسوخوالآخر بالسنة وهو علم الجرح والتعديل ومعرفة أحوال الرجال واعلم أن البحث عن أحوال الرجال في زماننا هذا مع طول المدة وكثرة الوسائط أمر كالمتعذر فالأولى الاكتفاء
بتعديل الأئمة الذين اتفق الخلق على عدالتهم كالبخاري ومسلم وأمثالهما وقد ظهر مما ذكرنا أن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه وأما سائر العلوم فغير مهمة في ذلك أما الكلام فغير معتبر لأنا لو فرضنا إنسانا جازما بالإسلام تقليدا لأمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام وأما تفاريع الفقه فلا حاجة إليها لأن هذه التفاريع ولدها المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد فكيف تكون شرطا فيه
واعلم أن الإنسان كلما كان أكمل في هذه العلوم التي لا بد منها في الاجتهاد كان منصبه في الاجتهاد أعلى وأتم وضبط القدر الذي لا بد منه على التعيين كالأمر المتعذر
مسألة
الحق أنه يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن بل في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهملنا
أن الأغلب من الحادثة في الفرائض أن يكون أصلها في الفرائض دون المناسك والإجارات فمن عرف ما ورد من الآيات والسنن والإجماع والقياس في باب الفرائض وجب أن يتمكن من الاجتهادوغاية ما في الباب أن يقال لعله شذ منه شيء ولكن النادر لا عبرة به كما أن المجتهد المطلق وإن بالغ في الطلب فإنه يجوز أن يكون قد شذ عنه أشياء
الركن الثالث
المجتهد فيه
وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا ب الشرعي عن العقليات ومسائل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع وقال أبو الحسين البصري رحمه الله المسألة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الأحكام الشرعية وهذا ضعيف لأن جواز اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسألة اجتهادية فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم فيها لزم الدورالركن الرابع
حكم الاجتهاد وفيه مسائل
مسألةذهب الجاحظ وعبيد الله بن الحسن العنبرى إلى أن كل مجتهد في الأصول مصيب وليس مرادهم من ذلك مطابقة الاعتقاد فإن فساد ذلك معلوم بالضرورة وإنما المراد نفي الإثم والخروج عن عهدة التكليف
واتفق سائر العلماء على فساد هذا القول
حجة الجمهور أمور
الأول أن الله تعالى وضع على هذه المطالب أدلة قاطعة ومكن العقلاء من معرفتها فوجب أن لا يخرجوا عن العهدة إلا بالعلمالثاني أنا نعلم بالضرورة أنه عليه الصلاة و السلام أمر اليهود والنصارى بالإيمان به وذمهم على إصرارهم على عقائدهم وقاتل بعضهم وكان يكشف عمن بلغ منهم ويقتله ونعلم قطعا أن المعاند العارف مما يقل وإنما الأكثر مقلدة عرفوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه
الثالث التمسك بقوله تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم
وعلى الجملة ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه و سلم من الكفار مما لا ينحصر من الكتاب والسنة
أجاب الخصم عن الأول
بأنا لا نسلم بأنه تعالى وضع على هذه المطالب أدلة قاطعة ومكن العقلاء من معرفتها وكيف لا نقول ذلك ونرى الخلق مختلفين في الأديان والعقائد من زمان وفاة الرسول عليه الصلاة و السلاموإذا نظرنا في أدلة المختلفين في هذه المسائل وأنصفنا لم نجد واحدا منهم مكابرا قائلا بما يقطع العقل بفساده
سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن ذلك يقتضي كونهم مأمورين بالعلم ولم لا يجوز أن يقال إنهم أمروا بالظن الغالب سواء كان مطابقا أو غير مطابق وعلى هذا التقدير يكون الآتي به معذورا
ثم الذي يدل على أن التكليف لم يقع إلا بالظن الغالب وجهان
الأول أن اليقين التام المتولد من الدليل المركب من المقدمات البديهية تركيبا معلوم الصحة بالبديهة إن أمكن فهو عزيز نادر الوجود لا يفي به إلا الفرد بعد الفرد فلا يجوز أن يكون ذلك تكليفا لكل الخلق لأنه عليه الصلاة و السلام قال بعثت بالحنيفية السهلة السمحة وأي حرج فوق أن يكلف الإنسان في الساعة الواحدة معرفة ما عجز الخلق عن معرفته في خمسمائة سنة
الثاني أنا كما نعلم بالضرورة أن الصحابة ما كانوا متبحرين في دقائق الهندسة والهيئة والأرثماطيقى نعلم بالضرورة أنهم
ما كانوا عالمين بهذه الأدلة والدقائق والجواب عن شبهات الفلاسفة مع أنه عليه الصلاة و السلام حكم بصحة إيمانهم فدل ذلك على أن التكليف ما وقع بالعلم
سلمنا أنهم كلفوا بالعلم في هذه الأصول فلم قلت إن المخطىء فيه معاقب ودعوى الإجماع فيه غير جائزة لأنها دعوى الإجماع في محل الخلاف
وعن الثاني أنه عليه الصلاة و السلام كان يقبلهم لجهلهم بالحق أو لإصرارهم على ترك التعلم وطلب المعرفة
الأول ممنوع والثاني مسلم فلعله عليه الصلاة و السلام لما بالغ في إرشادهم إلى الحق ثم إنهم لم يلتفتوا إلى بيانه واشتغلوا باللهو والطرب وأصروا على ترك الطلب قتلهم
وأما من بالغ في الطلب والبحث ولكن عجز عن الوصول فلم قلت إنه عليه الصلاة و السلام قتل مثل هذا الإنسان سلمنا أنه قتله لكن لم قلت إنه لا بد وأن يكون معاقبا
وعن الثالث أنه ذم الكافر والكفر في أصل اللغة هو الستر ومعنى الستر لا يتحقق إلا في حق المعاند الذي عرف الدليل ثم أنكره أو في حق المقلد المصر الذي يعرف من نفسه أنه لا يعرف الدليل على صحة الشيء ثم إنه يقول به فأما العاجز المتوقف الذي بالغ في الطلب فلم يصل فهذا لا يكون ساترا لشيء ظهر عنده فلا يكون كافرا
ثم احتجوا على صحة قولهم بأنه تعالى رحيم كريم واستقراء أحكام الشرع يدل على أن الغالب على الشرع هو التخفيف والمسامحة حتى إنه لو احتاج إلى أدنى تعب في نفسه أو في ماله في طلب الماء سقط عنه فرض الوضوء وأبيح له التيمم فهذا الكريم الرحيم كيف يليق بكرمه ورحمته وعظم فضله أن يعاقب من أفنى طول عمره في الفكر والبحث والطلب
هذا حاصل كلامهم إلا أن الجمهور ادعوا انعقاد الإجماع على مذهبهم قبل حدوث هذا الخلاف
مسألة
اختلفوا في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية وضبط المذاهب فيه على سبيل التقسيم أن يقال المسألة الاجتهادية إما أن يكون لله تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم معين أو لا يكون فإن لم يكن لله تعالى فيها حكم فهذا قول من قال كل مجتهد مصيب وهم جمهور المتكلمين مناكالأشعري والقاضي أبي بكر ومن المعتزلة كأبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم وأتباعهم ثم لا يخلو أما أن يقال إنه وإن لم يوجد في الواقعة حكم إلا إنه وجد ما لو حكم الله تعالى بحكم لما حكم إلا به
وإما أن لا يقال بذلك أيضا
والأول هو القول بالأشبه وهو منسوب إلى كثير من المصوبينوالثاني قول الخلص من المصوبين أما إن قلنا إن في الواقعة حكما معينا عند الله فذلك الحكم إما أن لا يكون عليه إمارة ولا دلالة أو عليه إمارة وليس عليه دلالة أو عليه دلالة
أما القول الأول وهو أنه حصل الحكم ولكن من غير أمارة ولا دلالة فهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في كل واقعة ظاهر وإحاطة ونحن ما كلفنا بالإحاطة وهؤلاء زعموا أن ذلك الحكم مثل دفين يعثر عليه الطالب
بالاتفاق فلمن عثر عليه أجران ولمن اجتهد ثم غاب عنه أجر واحد وذلك الأجر على ما تحمل من الكد في الطلب لا على نفس الخيبة
وأما القول الثاني وهو أن عليه دليلا ظنيا فها هنا أيضا قولان
أحدهما أن المجتهد لم يكلف بإصابته لخفائه وغموضه فلذلك كان المخطىء معذورا ومأجورا وهو قول كافة الفقهاء وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما
وثانيهما أنه مأمور بطلبه أولا فإن أخطأ وغلب على ظنه شيء آخر فهناك يتعين التكليف ويصير مأمورا بأن يعمل بمقتضى ظنه ويسقط عنه الإثم تحقيقا
وأما القول الثالث وهو أن عليه دليلا قاطعا فهؤلاء
اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه لكنهم اختلفوا في موضعين
أحدهما أن المخطىء هل يستحق الإثم والعقاب أم لا فذهب بشر المريسي من المعتزلة إلى أنه يستحق الإثم والباقون اتفقوا على أنه لا يستحق
الثاني أنه هل ينقض قضاء القاضي فيه قال الأصم
ينقض وقال الباقون لا ينقض فهذا تفصيل المذاهب والذي نذهب إليه أن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا وأن عليه دليلا ظاهرا لا قاطعا وأن المخطىء فيه معذور وقضاء القاضي فيه لا ينقض
فلنتكلم أولا في بيان أن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا
لنا وجوه
الأول أن أحد المجتهدين إذا اعتقد رجحان الأمارة الدالة على الثبوت والمجتهد الثاني اعتقد رجحان الأمارة الدالة على العدم فنقول أحد هذين الاعتقادين خطأ والخطأ منهي عنه
بيان الأول أن إحدى الأمارتين إما أن تكون راجحة على الأخرى أو لا تكون فإن كانت إحداهما راجحة على الأخرى كان اعتقاد رجحانه صوابا أما اعتقاد رجحان الجانب الآخر يكون غير مطابق للمعتقد فيكون خطأ وإن لم تكن إحداهما راجحة على الأخرى كان كل واحد من الاعتقادين غير مطابق للمعتقد وعلى كل التقديرات لا يكون الإعتقادان مطابقين بل أحدهما يكون مطابقا للمعتقد فثبت أن كل مجتهد ليس بمصيب بمعنى كون اعتقاده مطابقا للمعتقد وهذه إحدى صور الخلاف فإن اكتفينا به جاز
وإن أردنا بيان أن الكل ليس بمصيب بمعنى أنهم ما أتوا بما كلفوا به قلنا الدليل عليه أن الاعتقاد الذي لا يكون مطابقا للمعتقد جهل والجهل بإجماع الأمة غير مأمور به
فثبت أيضا أن الكل ليسوا بمصيبين بمعنى الإتيان بالمأمور به
فإن قيل لا نسلم أن أحد الاعتقادين خطأ قوله لأن أحدهما اعتقد فيما ليس براجح أنه راجح وذلك خطأ قلنا اعتقد فيما ليس براجح أنه راجح في نفسه أو أنه راجح في ظنه
الأول ممنوع والثاني مسلم
بيانه أن المجتهد لا يعتقد كون أمارته راجحة على أمارة صاحبه في نفس الأمر ولكنه يعتقد كونها راجحة في ظنه والرجحان في ظنه حاصل فكان الاعتقاد مطابقا للمعتقد غايته أنه لم يوجد الرجحان الخارجي لكن عدم الرجحان الخارجي لا يوجب عدم الرجحان الذهني فثبت أن كل واحد من الاعتقادين يمكن أن يكون صوابا
سلمنا أن كل واحد منهما اعتقد الرجحان في نفس الأمر ولكنه لم يجزم بذلك الرجحان بل جوز خلافه فلم قلت إن الاعتقاد إذا وجد معه هذا التجويز كان منهيا عنه وخرج عليه الجهل فإنه اعتقاد مخالف للمعتقد مع الجزم
والجواب
قوله اعتقد كونه راجحا في ظنه أو في نفس الأمر قلنا الرجحان في الذهن إما أن يكون نفس اعتقاد رجحانه في الخارج أو أمرا لا يثبت إلا معه لأنا نعلم بالضرورة أنا لو اعتقدنا في الشيء كون وجوده مساويا لعدمه فمع هذا الاعتقاد يمتنع أن يكون اعتقاد وجوده راجحا على اعتقاد عدمه فعلمنا أنه لا بد عند حصول هذا الظن من اعتقاد كونه راجحا في نفسه إما لأن الظن نفس هذا الاعتقاد أو لأنه لا ينفك عنه وعلى كلا التقديرين فالمقصود حاصل
قوله هذا الاعتقاد وإن كان غير مطابق لكنه غير جازم قلنا بل هو جازم لأن اعتقاد كون الشيء أولى بالوجود غير اعتقاد كونه موجودا واعتقاد كونه أولى بالوجود حاصل مع الجزم فإن المجتهد يقطع بأن أمارته نظرا إلى هذه الجهة أولى بالاعتبار
بلى إنه غير جازم بالحكم لكن الجزم بالأولوية لا يقتضي الجزم بالوقوع كما أنا نقطع بأن الأولى بالغيم الرطب في زمان الخريف أن يكون ممطرا مع أنه قد لا يوجد المطر وعدم المطر لا يقدح في تلك الأولوية بل تلك الأولوية مقطوع بها فكذا ها هنا فثبت أنه حصل لأحد المجتهدين اعتقاد جازم غير مطابق فيكون خطأ وجهلا ومنهيا عنه
الطريقة الثانية المجتهد إما أن يكون مكلفا في الحكم بناءا على طريق أو لا بناء على طريق والثاني باطل لأن القول في الدين بمجرد التشهي باطل بإجماع المسلمين فإذن لا بد من طريق
فذلك الطريق إما أن يكون خاليا عن المعارض أو لم يكن خاليا عنه فإن كان الأول وهو كونه خاليا عن المعارض تعين ذلك الحكم بإجماع الأمة فيكون تاركه مخطئا وإن كان له معارض فإما أن يكون أحدهما راجحا على الآخر أو لا يكون فإن كان أحدهما راجحا على الآخر وجب العمل بالراجح لأن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز العمل بالأضعف عند وجود الأقوى فيكون مخالفه مخطئا وإن لم يكن أحدهما راجحا فحكم تعارض الأمارتين أما التخيير أو التساقط والرجوع إلى غيرهما وعلى كلا القولين فحكمه معين فمخالفه يكون مخطئا فثبت أن المصيب واحد على كل التقديرات فإن قيل لم لا يجوز أن يكون مكلفا بالحكم لا على طريق قوله الحكم في الدين بمجرد التشهي غير جائز قلنا غير جائز في موضع وجد فيه الدليل أو في موضع لم يوجد فيه الدليل
الأول مسلم والثاني ممنوع
بيانه أن العمل بالدليل مشروط بوجود الدليل وإلا كان ذلك تكليفا بما لا يطاق وفي هذه المسائل الاجتهادية لا دليل لأنه لو وجد لكان تارك العمل به تاركا للمأمور به فيكون عاصيا فيكون مستحقا للنار على ما مر تقديره في مسألة أن الأمر للوجوب ولما اجمعوا على أنه لا يستحق النار علمنا أنه لا دليل وإذا لم يوجد الدليل جاز العمل بمجرد الحدس والتوهم كما اشتبهت عليه أمارات القبلة فإنه يجوز له العمل بمجرد الحدس والتوهم سلمنا أنه أمر بالحكم بناء على طريق لكن لم لا يجوز أن يحصل في مقابلته طريق آخر فيكون أحدهما راجحا على الآخر قوله أجمعوا على وجوب العمل بالراجح قلنا العمل بالراجح واجب على من علم ذلك الرجحان أو على من لم يعلمالأول مسلم والثاني ممنوع
بيانه أن الأمارة الراجحة يجب العمل بها على من اطلع عليها أما من لم يطلع عليها فجاز أن يكلفه العمل بالأضعف فإنه غير مستبعد في العقل أن تكون مصلحة أحد المجتهدين في العمل بأقوى الأمارات ومصلحة الآخر في العمل بأضعفها
ومتى كان ذلك فإن الله تعالى يخطر على قلب من مصلحته العمل بأقواها وجوه الترجيح ويشغل الآخر عنها فيظن أنها أقوى الأمارات لأن مصلحته العمل على أضعف الأمارات والظن بكونها أقوى الأمارات مع كونها في نفسها أضعف الأمارات لا يقبح ألا ترى أنه لا يقبح الظن بكون زيد في الدار وإن لم يكن فيها وإذا ثبت أن هذا الذي قلنا جائز عقلا فما الدليل على أنه غير واقع
والجواب
قوله إنما يجب العمل به عند وجود الدليل وها هنا لا دليل
قلنا الدليل على وجود الدليل الظاهر إجماع الأمة على وجود الترجيح بأمور حقيقية لا خيالية ووجود الترجيح يستدعي وجود أصل الدليل أعني القدر المشترك بين الدليل اليقيني والدليل الظاهري
قوله يجوز العمل بالأضعف إذا لم يعرف الأقوى قلنا مقدار رجحان القوي على الضعيف أما أن يكون الاطلاع عليه ممكنا أو لا يكون
فإن لم يكن ذلك لم يكن ذلك القدر معتبرا في حق المكلف وإلا كان تكليفا بما لا يطاق فيكون القدر المعتبر بين الأمارتين في حق المكلف مساويا لا راجحا وإن أمكن الاطلاع عليه فإما أن يجب على المكلف تحصيل العلم بتلك الأمارة إلى أقصى الإمكان أو لا يجب
فإن كان الأول كان من لم يصل في معرفتها إلى أقصى الإمكان تاركا للواجب فيكون مخطئا
وإن كان الثاني فهو محال لأنه إما أن يكون هناك
حد ما متى لم يصل إليه لم يكن معذورا وإذا وصل إليه لم يكلف بالزيادة عليه وإما أن لا يكون الأمر كذلك
فإن كان الأول وجب أن يكون من لم يصل إلى ذلك الحد المعين مخطئا ومن وصل إليه يكون مصيبا وهذا خلاف الإجماع لأنه لم يدع أحد من الأمة حدا معينا في الاجتهاد بحيث أن المجتهد متى لم يصل إليه كان مخطئا وغير معذور ومتى وصل إليه كان مصيبا
وأما الثاني وهو أن لا يكون هناك حد معين فحينئذ لا تكون التخطئة عند بعض المراتب أولى منها عند بعض فإما أن لا يخطىء أصلا فيكون العمل بالظن كيف كان ولو مع ألف تقصير مصيبا وهذا باطل في الإجماع أو لا يكون مخطئا إلا إذا وصل إلى النهاية الممكنة وهو المطلوب
الطريقة الثالثة المجتهد يستدل بشيء على شيء والاستدلال عبارة عن استحضار العلم بأمور يلزم من وجودها وجود
المطلوب واستحضار العلم بالشيء متوقف على وجود ذلك الشيء فالاستدلال متوقف على وجود الدليل ووجود ما يدل على الشيء متوقف على وجود ذلك الشيء والاستدلال على الشيء يتوقف على وجود المدلول لأن دلالته عليه نسبة بينه وبين المدلول والنسبة بين الأمرين متوقفة في الثبوت على كل واحد منهما فوجود المطلوب متقدم على الاستدلال بمراتب والظن متأخر عن الاستدلال لأنه نتيجته وأثره فلو كان الحكم لا يحصل إلا بعد الظن كان المتقدم على الشيء بمراتب نفس المتأخر عن الشيء بمراتب وهو محال
الطريقة الرابعة المجتهد طالب والطالب لا بد له من مطلوب متقدم في الوجود على وجود الطلب فلا بد من ثبوت حكم قبل وجود الطلب وإذا كان كذلك كان مخالف ذلك الحكم مخطئا فإن قلت لا نسلم أن المجتهد يطلب حكم الله تعالى بل إنما يطلب غلبة الظن
ومثاله من كان على ساحل البحر فقيل له إن غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوب وإن غلب على ظنك العطب حرم عليك الركوب وقبل حصول الظن لا حكم لله تعالى عليك وإنما حكمه يترتب على ظنك بعد حصوله فهو يطلب الظن دون الإباحة والتحريم
قلت المجتهد أما أن يطلب الظن كيف كان أو ظنا صادرا عن النظر في أمارة تقتضيه
الأول باطل بإجماع الأمة فثبت أنه يطلب ظنا صادرا عن النظر في الأمارة والنظر في الأمارة متوقف على وجود الأمارة ووجود الأمارة متوقف على وجود المطلوب فثبت أن طلب الظن متوقف على وجود المدلول بمراتب فلو كان وجود المدلول متوقفا على حصول الظن لزم الدور وهذا غير ما قررناه في الطريقة الثانية
واحتج القائلون بأنه لا حكم لله تعالى في الواقعة بأمور
أحدها لو كان في الواقعة لله حكم لكان إما أن يكون عليه دليل وأعني بالدليل القدر المشترك بين ما يفيد الظن وبين ما يفيد اليقين أو لا يكون والقسمان باطلان فبطل القول بثبوت الحكم أما الملازمة فظاهرة
وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون عليه دليل لأنه لو كان عليه دليل لكان المكلف متمكنا من تحصيل العلم أو الظن به فكان الحاكم بغيره حاكما بغير ما أنزل الله تعالى فيلزم تكفيره لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وتفسيقه لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون والقطع بأنه من أهل النار لأنه يكون تاركا لما أمر الله به وتارك المأمور به عاص والعاصي من أهل النار لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولما أجمعت الأمة على فساد هذه اللوازم علمنا أنه ليس على الحكم دليل
فإن قلت هذه العمومات مخصوصة لأن أدلة هذه الأحكام غامضة فيكون التكليف باتباعها حرجا وذلك منفي بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج
قلت غموض أدلة هذه الأحكام لا يزيد على غموض أدلة المسائل العقلية مع كثرة مقدماتها وكثرة الشبه فيها وكون الخطأ فيها كفرا وضلالا فكذا ها هنا
وإنما قلنا إنه لا يجوز أن لا يكون عليه دليل لأنه لو كان كذلك لكان التكليف به تكليفا بما لا يطاق وأنه غير جائز فثبت بما ذكرنا فساد القسمين ويلزم من فسادهما القطع بأنه لا حكم في الواقعة ألبتة
وثانيها أن الأمة مجمعة على أن المجتهد مأمور بأن يعمل على وفق ظنه ولا معنى لحكم الله إلا ما أمر به وإذا كان مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه فإذا عمل به كان مصيبا لأنه يقطع بأنه عمل بما أمره الله به فوجب أن يكون كل مجتهد مصيبا
وثالثها لو وجد الحكم لوجد عليه دليل قاطع لكن لم يوجد عليه دليل قاطع فوجب أن لا يوجد الحكم ألبتة
بيان الملازمة
هو أن بتقدير وجود الحكم إما أن يوجد عليه دليل أو لا يوجد عليه دليل فإن لم يوجد عليه دليل ألبتة كان التكليف بذلك الحكم تكليف ما لا يطاق وإن وجد عليه دليل فذلك الدليل إما أن يكون مستلزما لذلك المذكور قطعا أو ظاهرا أو لا قطعا ولا ظاهراوالقسمان الأخيران باطلان أما أنه لا يجوز أن لا يستلزمه قطعا فالأمر فيه ظاهر لأن الذي يكون كذلك استحال أن يتوصل به إلى ثبوت المدلول وأما أنه لا يجوز لا أن يستلزمه ظاهرا فلأن هذا الدليل إما أن يمكن وجوده بدون المدلول أو لا يمكن فإن لم يمكن كان مستلزما له قطعا لا ظاهرا وإن أمكن وجود الدليل بدون ذلك المدلول في بعض الصور فلو استلزمه في صورة أخرى فلا يخلو إما أن تتوقف صيرورته مستلزما على انضمام قيد إليه أو لا تتوقف
فإن توقف على انضمام قيد إليه كان المستلزم للمدلول ذلك المجموع لا ذلك الذي فرضناه أولا دليلا
وإن لم يتوقف على انضمام قيد إليه فذلك الشيء تارة ينفك عن المدلول وأخرى يستلزمه من غير انضمام قيد إليه لا بالنفي ولا بالإثبات فيلزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح وذلك محال
وإذا ثبت أن المستلزم هو ذلك المجموع فذلك المجموع إن أمكن انفكاكه عن المدلول استحال أن يستلزم المدلول إلا بقيد آخر فإما أن يتسلسل وهو محال أو ينتهي إلى شيء يمتنع انفكاكه عن المدلول فحينئذ يكون دليلا قطعيا لا ظاهرا فإن قلت الدليل الظاهر هو الذي يستلزم كون المدلول أولى بالوجود أو كونه غير منته إلى الوجوب وهذا المعنى ملازم له أبدا قلت الأولوية التي لا تنتهي إلى حد الوجوب ممتنعة لأن مع تلك الأولوية إن امتنع العدم فذلك هو الوجوب
وإن لم يمتنع فتلك الأولوية يمكن حصولها مع الوجود تارة ومع العدم أخرى ورجحان أحدهما على الآخر إن توقف على انضمام قيد زائد لم يكن الحاصل أولا كافيا في الرجحان
وان لم يتوقف لزم رجحان الممكن من غير مرجح وهو محال فثبت بهذا البرهان القاطع أن الذي لا يستلزم الشيء
قطعا استحال أن يستلزمه بوجه من الوجوه لا ظنا ولا ظاهرا
فثبت أنه لو وجد في الواقعة حكم معين لوجد عليه دليل قاطع ولما انعقد الإجماع على أنه ليس كذلك علمنا أنه ليس في الواقعة حكم ألبتة
ورابعها لو حصل في الواقعة حكم معين لكان ما عداه باطلا ولو كان كذلك لزم أمور أربعة
أحدها يلزم أن لا يجوز لأحد من الصحابة أن يولي بعضهم بعضا مع علمهم بكونهم مخالفين لهم في مذاهبهم لأن التمكين من ذلك تمكين من ترويج الباطل وإنه غير جائز لكنه قد وقع ذلك روي أن أبا بكر رضي الله عنه ولى زيدا مع أنه كان يخالفه في الجد وولى علي رضي الله عنه شريحا مع أنه كان يخالفه في كثير من الأحكام
وثانيها يلزم أن لا يمكنه من الفتوى وقد كانوا يفعلون ذلك
وثالثها كان يجب أن ينقضوا أحكام مخالفيهم وأن ينقض الواحد منهم
حكم نفسه الذي رجع عنه لأن كثيرا منهم قضى بقضايا مختلفة لكن لم ينقل عن أحد منهم أنه نقض حكم غيره ولا حكم نفسه عند رجوعه عنه
ورابعها أنهم اختلفوا في الدماء والفروج والخطأ في ذلك يكون كبيرا لأنه لا فرق بين أن يمكن غيره بفتواه بالباطل من القتل وأخذ المال وبين أن يقتل ويأخذ المال ويصرفه إلى غير المستحق ابتداء في كونه كبيرا ويجب تفسيق فاعله والبراءة عنه ولما لم يوجد شيء من هذه اللوازم الأربعة علمنا أنه لا حكم في الواقعة أصلا
فإن قلت فلم لا يجوز أن يقال ذلك الخطأ كان من باب الصغائر فلا جرم لم يجب الامتناع عن التولية ولا المنع من الفتوى ولا البراءة ولا التفسيق سلمنا أنه كبيرة فلم لا يجوز أن يقال هذه الأمور إنما تلزم لو حصل في هذه المسائل طريق مقطوع به أما إذا كثرت وجوه الشبه وتزاحمت جهات التأويلات والترجيحات صار ذلك سببا للعذر وسقوط اللوم
سلمنا صحة دليلكم لكنه معارض بوجوه
الأول ما روي عن الصحابة من التصريح روي عن الصديق الأكبر رضي الله عنه أنه قال في الكلالة أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله تعالى وإن كان خطأ فمنى واستغفر الله
وعن عمر رضي الله عنه أنه حكم بحكم فقال له بعض الحاضرين هذا والله هو الحق وحكم بحكم آخر فقال له الرجل هو والله الحق فقال له عمر إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق لكنه لا يألوا جهدا
وقال أيضا لكاتبه اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنه
وقال علي لعمر في قصة المجهضة إن قاربوك فقد غشوك وإن اجتهدوا فقد أخطأوا
وقال ابن مسعود في المفوضة أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله عنه بريئان
ونقل أن جماعة الصحابة خطأوا ابن عباس في إنكار العول وقال ابن عباس ألا يتقي الله زيد بن ثابت
الثاني أن الصحابة اختلفوا قبل العقد لأبي بكر رضي الله عنه فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير وكانوا مخطئين لمخالفتهم قوله عليه الصلاة و السلام الأئمة من قريش
ولم يلزم من ذلك الخطأ إظهار البراءة والتفسيق فكذا ها هنا
الثالث اختلفوا في أن مانع الزكاة هل يقاتل وقضى عمر في الحامل المعترفة بالزنا بالرجم وكان ذلك على خلاف النص ولم يلزم تفسيق عمر فكذا ها هنا
وأما قوله في الوجه الرابع إنهم اختلفوا في الدماء والفروج والخطأ فيها كبير قلنا لا نسلم فإنه لما لم يمتنع أن تكون الأقوال المختلفة صوابا على مذهبكم فلم لا يجوز أن يكون الخطأ فيها صغيرا وقوله لا فرق بين القتل والغصب ابتداء وبين التمكين منهما بالفتوى الباطلة
قلنا لا نسلم ولم لا يجوز أن يكون تمسكه في ذلك بما يشبه الدليل سببا لسقوط العقاب والتفسيق
قلت أما الجواب عن الأول
فالذي يدل على أنه لو كان خطأ لكان من الكبائر لا من الصغائر أن تارك العمل به تارك للعمل المأمور به فيكون عاصيا فيكون مستحقا للناروعن الثاني أن غموض الأدلة وكثرة الشبه فيها ها هنا أقل مما في العقليات مع أن المخطىء فيها كافر أو فاسق
وعن الثالث أن نقول ترك البراءة والتفسيق مع التمكين من الفتوى والعمل منقول عن هؤلاء الذين نقلتم عنهم التصريح بالتخطئة فلا بد من التوفيق وقد تعذر صرفه إلى كون الخطأ صغيرا لما بينا فساده فإذن لا طريق في التوفيق إلا صرف ما نقلناه إلى قسم وما نقلتموه إلى قسم آخر وذلك لآنا
لا ندعي التصويب في كل المسائل الشرعية حتى يضرنا ما ذكرتموه أما أنتم فتدعون الخطأ في كل الاختلافات فيضركم ما ذكرناه فنحمل التخطئة على ما إذا وجد في المسألة نص قاطع أو على ما إذا لم يستقص المجتهد في وجوه الاستدلال وقوله إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان معناه إن استقصيت في وجوه النظر والاستدلال فمن الله وإن قصرت فمني ومن الشيطان
وأما المعارضة الثانية فجوابها أن الأنصار ما سمعوا ذلك الحديث فلا جرم لم يستحقوا التفسيق والبراءة بخلاف هذه المسائل فإن كل واحد من المجتهدين عرف حجة صاحبه وأطلع عليها فلو كان مخطئا لكان مصرا على الخطأ بعد اطلاعه عليه فأين أحد البابين من الباب الآخر
وهذا هو الجواب أيضا عن اختلافهم في مانعي الزكاة وقصة المجهضة
قوله على الوجه الرابع لما جاز أن تكون المذاهب المختلفة في الدماء والفروج خفية فلم لا يجوز أن يكون الخطأ فيها صغيرا لا كبيرا قلنا قد ذكرنا الدليل على أن الخطأ في هذا الباب لا بد وأن يكون كبيرا
ولأنه روي أنه عليه الصلاة و السلام قال من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله فهذا وأمثاله من الأحاديث التي لا حد لها يدل على أنه لو كان
المفتي في هذه الوقائع مخطئا لكان خطؤه كبيرة لا صغيرة
وخامسها لو كان المجتهد مخطئا لما حصل القطع بكون الخطأ فيه مغفورا وقد حصل ذلك فهو ليس بمخطىء
بيان الملازمة
أنه لو حصل القطع بكون الخطأ مغفورا لكان في ذلك الوقت إما أن يجوز المخطىء كونه مخلا بنظر يلزمه فعله أو لا يجوز ذلكفإن لم يجوز ذلك كان كالساهي عن النظر الزائد فلم يكن مكلفا بفعله وإذا لم يكن مكلفا بفعله لم يستحق العقاب بتركه فلا يكون مخطئا وقد فرض مخطئا هذا خلف
وإن جوز كونه مخلا بنظر زائد لم يخل إما أن يعلم في تلك الحالة أنه مغفور له إخلاله بذلك النظر الزائد أو لا يعلم ذلك
فإن علم ذلك لم يصح لأن المجتهد لا يعلم المرتبة التي إذا انتهى إليها غفر له ما بعدها لأنه إن اقتصر على أول المراتب لم يغفر له ما بعدها وما من مرتبة ينتهي إليها إلا ويجوز أن لا يغفر له ما بعدها ولا تتميز بعض تلك المراتب من بعض ولأنه لو عرف تلك المرتبة لكان مغري بالمعصية لأنه علم أنه لا مضرة عليه في ترك النظر الزائد مع كونه مثابا عليه
فثبت أنه لا يعرف تلك المرتبة وإذا لم يعرفها جوز أن لا يغفر له إخلاله بما بعدها من النظر وجوز أيضا في كل مخطىء من المجتهدين أنهم ما انتهوا إلى المرتبة التي يغفر لهم ما بعدها وفي ذلك تجويز كونهم غير مغفور لهم
فثبت أنه لو كان مخطئا لما حصل القطع بكونه مغفورا له لكنه حصل القطع بذلك لأنهم اتفقوا من لدن عصر الصحابة إلى يومنا هذا أن ذلك مغفور لهم فعلمنا أن المجتهد ليس بمخطىء
وسادسها قوله عليه الصلاة و السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم خير الناس في تقليد أعيان الصحابة
وكان الصحابة مختلفين في المسائل فلو كان بعضهم مخطئا في الحكم أو في الاجتهاد لكان قد حثهم على الخطأ والمصير إليه وإنه لا يجوز
وسابعها قوله عليه الصلاة و السلام لمعاذ لما رتب الاجتهاد على السنة والسنة على الكتاب أصبت حكم بتصويبه مطلقا ولم يفصل بين حالة وحالة فعلمنا أن المجتهد مصيب على الإطلاق
والجواب عن الأول
أن على الحكم دليلا ظاهرا لا قطعيا قوله لزم كفر تاركه وفسقه بالآيات قلنا عندنا أن المجتهد قبل الخوض في الاجتهاد كان تكليفه أن يطلب ذلك الحكم الذي عينه الله تعالى ونصب عليه الدليل الظاهر فإذا اجتهد وأخطأ ولم يصل إلى ذلك الحكم وغلب على ظنهشيء آخر تغير التكليف في حقه وصار مأمورا بأن يعمل بمقتضى ظنه وعلى هذا التقدير يكون حاكما بما أنزل الله تعالى لا بغير ما أنزل الله فيسقط ما ذكروه من الاستدلال
وهذا هو الجواب أيضا عن الحجة الثانية
لأنا نسلم أن المجتهد بعد أن اجتهد وغلب على ظنه أن الحكم كذا فإنه يكلف بأن يعمل بمقتضى ذلك الظن وحكم الله تعالى في هذه الحالة في حقه ليس إلا ذلك لكن لم لا يجوز أن يقال إنه قبل الخوض في الاجتهاد كان مأمورا بذلك الحكم الذي عينه الله تعالى ونصب عليه الدليل لكنه بعد الاجتهاد ووقوع الخطأ تغير التكليف وما ذكروه لا ينفي هذا الإحتمالوأيضا
فهذه الدلالة منقوضة بما إذا كان النص موجودا في المسألة والمجتهد طلبه ولم يجده ثم غلب على ظنه بمقتضىالقياس خلاف ذلك الحكم فإن كان تكليفه في هذه الحالة أن يعمل بمقتضى ذلك القياس مع انعقاد الإجماع على كونه مخطئا في هذه الصورة فما جعلوه جوابا لهم عن هذه الصورة فهو جوابنا عما قالوه واعلم أن من المصوبة من منع التخطئة في هذه الصورة والمعتمد ما قدمناه
وهو الجواب عن الوجه الثالث الذي ذكروه وعن الوجه الرابع
لأنه إنما يجب البراءة والتفسيق لو كان عاملا بغير حكم الله تعالى لكنه بعد الخطأ مكلف بأن يعمل بمقتضى ظنه فيكون عاملا بحكم الله تعالى فلا يلزم شيء مما ذكروهوعن الخامس أن المرتبة التي عندها يحكم بكونه مغفورا هي أن يأتي بما يقدر عليه من غير تقصير
وعن السادس أنه معارض بقوله عليه الصلاة و السلام من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وأيضا فهو خبر واحد وما ذكرناه دلائل قاطعة فلا يحصل التعارض
وهو الجواب عن الوجه السابع
واعلم أنا نريد أن نتكلم في فروع القول بالتصويبمسألة
الذين قالوا ليس في الواقعة حكم معين منهم من قال ب الأشبه على التفسير الذي لخصناه ومنهم من لم يقل به وهو الحق
لنا
أن ذلك الأشبه إما أن يكون هو العمل بأقوى الأمارات أو غيره فإن كان الأول فأقوى الأمارات إما أن يكون موجودا أو لا يكونفإن كان موجودا كان الأمر به واردا لإجماع الأمة على وجوب العمل بأقوى الأمارات فحينئذ يكون الحكم بذلك الأشبه واردا وقد فرضناه غير وارد هذا خلف وإن كان أقوى الأمارات غير موجود لم يكن الأشبه أيضا موجودا لأنا فرضنا أن الأشبه هو نفس أقوى الأمارات وأما إن كان الأشبه شيئا غير العمل بأقوى الأمارات فإما أن تكون مفسدة للمكلف أو مصلحة له أو لا مفسدة ولا مصلحة
والأول باطل لأنه ليس في الأمة أحد يقول إنه يجب أن يكون في كل واقعة حكم لو نص الله تعالى على الحكم لنص عليه مع أنه يكون مفسدة
وأما الثاني وهو أن يكون مصلحة فإما أن تجب على الله تعالى رعاية المصالح أو لا تجب فان وجبت وجب عليه التنصيص على ذلك الحكم ليتمكن المكلف من استيفاء تلك المصلحة وإن لم تجب عليه رعاية المصلحة جاز منه تعالى أن ينص على غير ذلك الحكم وذلك يبطل القول بأنه لو نص على الحاكم لما نص إلا عليه
وأما الثالث وهو أن يكون ذلك الأشبه لا مصلحة ولا مفسدة فهذا إنما يمكن لو قلنا إنه لا تجب عليه رعاية المصالح وكل من قال بهذا القول قال إنه لا يتعين عليه تعالى أن يحكم على وجه معين بل له أن يحكم كيف شاء وذلك يمنع من القول بتعين الأشبه
واحتج القائلون بالأشبه بالنص والمعقول
أما النص فقوله عليه الصلاة و السلام إذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر واحد صرح بالتخطئة وهذه التخطئة ليست لأجل مخالفة حكم واقع لأنا قد دللنا على أنه لا حكم فلا بد وأن يكون لأجل كونه مخالفا لحكم مقدر وهو الأشبه
وأما المعقول فهو أن المجتهد طالب والطالب لا بد له من مطلوب ولما لم يكن المطلوب معينا وقوعا وجب أن يكون معينا تقديرا
والجواب
أن ذلك الأشبه إن كان هو العمل بأقوى الأمارات فهو حق وهو قولناوإن كان غيره مع أن الله تعالى لم ينص عليه ولا أقام عليه دلالة ولا أمارة فكيف يكون مخطئا بالعدول عنه و كيف ينقص ثوابه إذا لم يظفر بما لم يكلف بإصابته ولا سبيل له إلى إصابته وهذا هو بعينه الجواب عن الوجه المعقول
مسألة
القائلون بأن المصيب واحد احتجوا بأن القول بتصويب الكل يفضي إلى وقوع منازعة لا يمكن قطعها وهذا كما إذا نكح رجل امرأة وكانا مجتهدين ثم قال أنت بائن ثم راجعها والزوج شافعي يرى الرجعة والمرأة حنفية ترى الكنايات بوائن فها هنا الزوج متمكن شرعا من مطالبتها بالوطء والمرأة مأمورة بالامتناع وهذه منازعة لا يمكن قطعهاقال المصوبون هذا الإشكال وارد عليكم أيضا فإن أهل التحقيق منكم ساعدوا على أنه يجب على المجتهد العمل بموجب ظنه إذا لم يعرف كونه مخطئا فهذا الإلزام أيضا وارد عليكم
ولما كان هذا الإشكال واردا على المذهبين وجب أن نذكر تقسيما
في بيان الحوادث النازلة بالمكلفين ليظهر أنه لا نزاع فيها فنقول الحادثة إما أن تنزل بمجتهد أو بمقلد
فإن نزلت بمجتهد فإما أن تختص به أو تتعلق بغيره فإن اختصت به عمل بما يؤديه إليه اجتهاده فإن استوت عنده الأمارات تخير بينها أو يعاود الاجتهاد إلى أن يظهر الرجحان
وإن تعلقت بغيره فإن كان يجري فيه الصلح نحو التنازع في مال اصطلحا فيه أو رجعا إلى حاكم يفصل بينهما أن وجد فإن لم يوجد رضيا من يحكم بينهما ومتى حكم لم يكن لهما الرجوع عنه
وإن لم يجر الصلح فيه كما ذكرنا في مسألة الكنايات فإنهما يرجعان إلى من يفصل بينهما سواء كان صاحب الحادثة مجتهدا و حاكما أو لم يكن فإن الحاكم لا يجوز له أن يحكم لنفسه على غيره بل ينصب من يقضي بينهما
وإن كان مقلدا فإن كانت الحادثة تخصه عمل على ما اتفق عليه من الفتوى وإن اختلفوا عمل بفتوى الأعلم الأورع فإن استويا تخير بينهما وإن كانت تتعلق بغيره عمل كما بيناه في حق المجتهدين
مسألة في نقض الاجتهاد المجتهد إذا تغير اجتهاده ففيه بحثان
الأول أن المجتهد كيف يعملوالثاني أن العامى الذي عمل بفتواه كيف يعمل
أما الأول فنقول المجتهد إذا أفضى اجتهاده إلى أن الخلع فسخ فنكح امرأة خالعها ثلاثا ثم تغير اجتهاده فإما
أن يكون قد قضى القاضي بصحة ذلك النكاح قبل تغير اجتهاده أو ما قضى بذلك فإن كان الأول بقى النكاح صحيحا لأن قضاء القاضي لما اتصل به فقد تأكد فلا يؤثر فيه تغير الاجتهاد وإن كان الثاني لزم تسريحها ولم يجز له إمساكها على خلاف اجتهاده
وأما الثاني وهو ما إذا أمسك العامي زوجته بفتوى المفتي بأن الخلع فسخ فإذا تغير اجتهاد المفتي فالصحيح أنه يجب عليه تسريحها كما إذا تغير اجتهاد متبوعه عن القبلة في أثناء الصلاة فإنه يتحول إلى الجهة الأخرى بخلاف قضاء القاضي فإنه متى اتصل بالحكم المجتهد فيه استقر
واعلم أن قضاء القاضي لا ينتقض بشرط أن لا يخالف دليلا قاطعا فان خالفه نقضناه
الكلام في المفتي والمستفتي والنظر فيه يتعلق بالمفتي والمستفتي وما فيه
الاستفتاء
القسم الأول في المغتي وفيه مسائل
مسألة إذا أفتى المجتهد بما أدى إليه اجتهاده ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة فإما أن يكون ذاكرا لطريق الاجتهاد الأول أو لا يكون فإن كان ذاكرا له فهو مجتهد وتجوز له الفتوى وإن نسيه لزمه أن يستأنف الاجتهاد فإن أداه اجتهاده إلى خلاف فتواه في الأول أفتى بما أداه اجتهاده إليه ثانياثم الأحسن به أن يعرف من استفتاه أولا أنه رجح عن ذلك القول لأن ذلك المستفتي إنما يعول على قوله فإذا ترك هو قوله بقي عمل المستفتي به بعد ذلك عملا من غير موجب
روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في تحريم أم المرأة مشروط بالدخول بالمرأة فلقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وذاكرهم فكرهوا أن يتزوجها
فرجع ابن مسعود إلى من كان أفتاه قال سألت أصحابي فكرهوا
وأما إن لم يستأنف الاجتهاد لم تجز له الفتوى
ولقائل أن يقول لما كان الغالب على ظنه أن الطريق الذي تمسك به أولا كان طريقا قويا حصل له الآن ظن أن ذلك القوي حق جاز له الفتوى به لأن العمل بالظن واجب
مسألة
اختلفوا في أن غير المجتهد هل تجوز له الفتوى بما يحكيه عن الغير فنقول لا يخلوا إما أن يحكى عن ميت أو عن حي فإحكي عن ميت لم يجز الأخذ بقوله لأنه لا قول للميت بدليل أن الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيا وينعقد مع موته وهذا يدل على أنه لم يبق له قول بعد موته فإن قلت فلم صنفت كتب الفقه مع فناء أربابها قلت لفائدتين إحداهما استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض
والأخرى معرفة المتفق عليه من المختلف فيه ولقائل أن يقول إذا كان الراوي عدلا ثقة متمكنا من فهم كلام المجتهد الذي مات ثم روى للعامي قوله حصل للعامي ظن صدقه ثم إذا كان المجتهد عدلا ثقة فذلك يوجب ظن صدقه في تلك الفتوى
وحينئذ يتولد للعامي من هذين الظنين ظن أن حكم الله تعالى ما روى له هذا الراوى الحي عن ذلك المجتهد الميت والعمل بالظن واجب فوجب أن يجب على العامي العمل بذلك
وأيضا فقد انعقد الإجماع في زماننا هذا على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى لأنه ليس في هذا الزمان مجتهد والإجماع حجة
وأما إن حكى عن حي من أهل الاجتهاد فإما أن يكون سمعه مشافهة أو يرجع فيه إلى كتاب أو حكاية حال فإن كان سمعه منه مشافهة جاز أن يعمل به وجاز أن يعمل الغير أيضا بقوله ولهذا يجوز للمرأة أن تعمل في حكم حيضها بحكاية زوجها عن المفتين
ورجع علي رضي الله عنه إلى حكاية المقداد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في شأن المذي وإن رجع في ذلك إلى حكاية من يوثق بقوله فحكم ذلك حكم السماع وإن رجع إلى كتاب فإن كان كتابا موثوقا به جرى مجرى
المكتوب من جواب المفتي في أنه يجوز العمل به وإلا فلا لكثرة ما يتفق من الغلط في الكتب
القسم الثاني في المستفتي
مسألة يجوز للعامي أن يقلد المجتهد في فروع الشرع خلافا لمعتزلة بغداد وقال الجبائى يجوز ذلك فيما كان من مسائل الاجتهادلنا وجهان
الأول إجماع الأمة قبل حدوث المخالف لأن العلماء في كل عصر لا ينكرون على العامة الاقتصار على مجرد أقاويلهم ولا يلزمونهم أن يسألوهم عن وجه اجتهادهمالثاني أن العامي إذا نزلت به حادثة من الفروع فإما أن لا يكون مأمورا فيها بشيء وهو باطل بالإجماع لأنا نلزمه إلى قول العلماء والخصم يلزمه الرجوع إلى الاستدلال وإما أن يكون مأمورا فيها بشيء وذلك إما بالاستدلال أو بالتقليد والاستدلال باطل لأنه إما أن يكون هو التمسك بالبراءة الأصلية أو التمسك بالأدلة السمعية والأول باطل بالإجماع والثاني أيضا باطل لأنه لو لزمه أن يستدل لم يخل من أن يلزمه ذلك حين كمل عقله أو حين حدثت المحادثة
والأول باطل لوجهين
أحدهما أن الصحابة ما كانوا يلزمون من لم يشرع في طلب العلم ولم يطلب رتبة المجتهد في أول ما يكمل عقلهوثانيهما أن وجوب ذلك عليه يمنعه من الاشتغال بأمور الدنيا
وذلك سبب لفساد العالم
والثاني أيضا باطل لأنه يقتضي أن يجب عليه اكتساب صفة المجتهدين عند نزول الحادثة وذلك غير مقدور له
ولقائل أن يقول على هذا الوجه القائلون بأنه لا يجوز التقليد في الشرع لا يقولون بالإجماع ولا بخبر الواحد ولا بالقياس ولا يجوزون التمسك بالظواهر المحتملة
وإذا كان كذلك سها الأمر عليهم فإنهم قالوا قد تقرر في عقل كل عاقل أن الأصل في اللذات الإباحة وفي المضار الحرمة فإن جاء في بعض الحوادث نص قاطع المتن قاطع الدلالة يوجب ترك ذلك الأصل العقلي قلنا به
وإن لم يوجد ذلك وجب البقاء على حكم العقل وإذا ثبت هذا فالعامي إذا وقعت له واقعة فإما أن يكون فيه شيء من الذكاء أو لا يكون بل يكون في غاية البلادة فإن كان فيه شيء من الذكاء عرف حكم العقل فيه وإن كان في غاية البلادة نبهه المفتي على حكم العقل وليس لأحد أن يقول الاشتغال بذلك يمنعه عن عمل المعاش
لأنه إذا جاز تكليفه بمعرفة الأدلة الدقيقة في مسائل الأصول ولا يمنعه ذلك عن المعاش فكيف تمنعه معرفة هذا القدر من طلب المعاش
ثم إذا عرف العامي حكم العقل وأن ما في الواقعة نص يوجب ترك العمل بحكم العقل قاطع المتن قاطع الدلالة نبهه المفتي عليه ولا حاجة في فهم مثل هذا النص إلى تدقيق يمنعه من عمل المعاش
وإن لم يوجد فيه مثل هذا النص وجب عليه العمل بحكم العقل فثبت أن المنع من التقليد إنما يصعب على قول من يوجب العمل بالقياس وخبر الواحد أما من لا يقول بذلك فلا صعوبة عليه ألبتة
وأيضا فهذه الدلالة لو صحت لوجب القول بجواز التقليد في مسائل الأصول لأنا نعلم أن الوقوف على تلك الدلائل لا يحصل إلا بعد الكد الكثير ونحن نعلم من حال الصحابة أنهم ما كانوا يلومون من لم يتعلم علم الكلام في أول زمان بلوغه وأيضا الأشتغال بتحصيله يمنع من الاشتغال بأمر المعاش
أجابوا بأن الذي يجب على المكلف معرفة أدلة التوحيد
والنبوة على طريق الجملة لا على طريق التفصيل ومعرفة تلك الأدلة على سبيل الإجمال أمر سهل هين يحصل بأدنى سبب بخلاف الاجتهاد في فروع الشرع فإنه لا بد فيه من علوم كثيرة وتبحر شديد واعلم أن هذا الفرق إنما يتلخص إذا سلمنا لهم الفرق بين مباحث الجملة ومباحث التفصيل
وعندي أن هذا الفرق باطل وذلك لأن الدليل إذا كان مركبا مثلا من مقدمات عشر فالمستدل إن كان عالما بها بأسرها وجب حصول العلم النظري له لا محالة وان امتنعت الزيادة عليه لأن تلك المقدمات العشر إذا كانت مستقلة بالانتاج فلو انضمت مقدمة أخرى إليها استحال أن يكون لها أثر ألبتة
وأما إن لم يحصل العلم بأسرها مثل أن يحصل العلم بتسع منها ولم تكن المقدمة العاشرة معلومة بالضرورة ولا بالدليل بل مقبولة على سبيل التقليد فتكون النتيجة المتولدة عن مجموع تلك العشر تقليدا لا يقينا
فثبت أن التمسك بالدليل لا يقبل الزيادة والنقصان ألبتة
مثاله أنهم يقولون صاحب الجملة يكفيه الاستدلال بحدوث الحوادث من البرق والرعد والحر والبرد على وجود الصانع فنقول هذا لا يكفي لأنا نقول هذه الحوادث لا بد لها من مؤثر وذلك المؤثر يجب أن يكون فاعلا مختارا
أما المقدمة الأولى فمعلومة للعوام
وأما الثانية فغير معلومة لهم لأنه ما لم يثبت أن ذلك ليس أثرا لمؤثر موجب لم يجب أن يكون إسناده إلى المختار فإذا قطع العامي بأن ذلك المؤثر يجب أن يكون مختارا من غير دليل عليه كان مقلدا في هذه المقدمة وإذا كان مقلدا فيها لم يكن محققا في النتيجة
وأيضا إذا رأى حدوث فعل خارق للعادة على يد مدعي النبوة فلو قطع عند ذلك بنبوته كان ذلك تقليدا لأن قبل الدليل يجوز أن يكون ذلك الحادث ليس فعلا لله تعالى بل خاصية لنفس الرسول أو خاصية لدواء أو فعلا من أفعال الجن
وبتقدير أن يكون فعلا لله تعالى لكن يجوز أن لا يكون لله تعالى فيه غرض
وإن كان له فيه غرض جاز أن يكون ذلك الغرض شيئا سوى التصديق فلو قطع العامي بأن ذلك الفعل الخارق للعادة لا بد وأن يكون دالا على صدق المدعي من غير دليل يدل على فساد هذه الأقسام كان مقلدا في اعتقاد هذه المقدمة فلم يكن محققا في النتيجة فظهر بهذا فساد ما قالوه من الفرق بين صاحب الجملة وبين صاحب التفصيل
وحينئذ لا يبقى إلا أحد أمرين إما أن يقال بأن الإحاطة بأدلة الدين على تفصيلها وتدقيقها شيء سهل هين وذلك مكابرة وإما أن يقال يجوز فيه التقليد كما جوزوا في فروع الشرع التقليد وحينئذ لا يبقى بينهما فرق ألبتة
واحتج منكرو التقليد في فروع الشرع بأمور
أحدها قوله تعالى وأن تقولوا على الله مالا تعلمونوثانيها أن الله تعالى ذم أهل التقليد بقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على
أمة
وثالثها قوله عليه الصلاة و السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة توافقنا على خروج بعض العلوم عن هذا العموم فبقي العلم بفروع الشرع و أحكامه
ورابعها القول بجواز التقليد يفضي إلى بطلانه لأنه يقتضي جواز تقليد من يمنع من التقليد وما يفضي ثبوته إلى عدمه كان باطلا
وخامسها قوله عليه الصلاة و السلام اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له أمر بالإجتهاد مطلقا
وسادسها أن العامي إذا قلد لم يأمن من جهل المفتي وفسقه فيكون فاعلا للمفسدة
وسابعها لو جاز التقليد في فروع الشرع لكان ذلك لأنه حصلت أمارات توجب ظن صدق المفتي وهذا المعنى قائم في أصول الدين فوجب الاكتفاء بالفتوى في الأصول أيضا
والجواب عن الأول أنه منقوض بكل ظن وجب العمل به كما في أحوال الدنيا وقيم المتلفات وأروش الجنايات وبخبر الواحد والقياس إن سلموا جواز العمل بهما
وعن السادس والسابع أن نذكر الفرق الذي تقدم
وأما الدليل على أن للعامي أن يقلد في مسائل الاجتهاد وغير مسائل الاجتهاد أنا لو كلفناه أن يفصل بين البابين لكنا قد ألزمناه أن يكون من أهل الاجتهاد لأنه إنما يفصل بينهما أهل الاجتهاد فيعود المحذور المذكور
واحتج المخالف
بأن ما ليس من مسائل الاجتهاد فالحق فيها واحد فلو قلدنا فيها لم نأمن أن نقلد في خلاف الحق وليس كذلك مسائل الاجتهاد لأن كل قول فيها حقوالجواب أنا لا نأمن أيضا في مسائل الاجتهاد أن لا يجتهد المفتى أو يقصر في اجتهاده أو يفتيه بخلاف اجتهاده فإن قلتم إن مصلحة العامي هو أن يعمل بما يفتيه المفتي قلنا وكذلك الأمر في تقليده فيما نحن فيه وإن كان غير مصيب
مسألة في شرائط الاستفتاء
اتفقوا على أنه لا يجوز له الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن من يفتيه من أهل الاجتهاد ومن أهل الورع وذلك إنما يكون إذا رآه منتصبا للفتوى بمشهد الخلق ويرى اجتماع المسلمين على سؤاله واتفقوا على أنه لا يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم و لا متدين
وإنما وجب عليه ذلك لأنه بمنزلة نظر المجتهد في الأمارات ثم هاهنا بحث وهو أن أهل الاجتهاد إذا أفتوه فإن اتفقوا على فتوى لزم المصير إليها
وإن اختلفوا فقال قوم وجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لأن ذلك طريق قوة ظنه يجري مجرى قوة ظن المجتهد
وقال آخرون لا يجب عليه هذا الاجتهاد لأن العلماء في كل عصر لا ينكرون على العوام ترك النظر في أحوال العلماء
ثم بعد الاجتهاد إما أن يحصل ظن الاستواء مطلقا أو ظن الرجحان مطلقا أو ظن رجحان كل واحد منهما على صاحبه من وجه دون وجه
فإن حصل ظن الاستواء مطلقا فها هنا طريقان
أحدهما أن يقال هذا لا يجوز وقوعه كما لا يجوز استواء أمارتي الحل والحرمةوالآخر أن يقال يسقط عنه التكليف لأنا جعلنا له أن يفعل ما يشاء وأما إذا حصل ظن الرجحان مطلقا تعين العمل به أما إذا حصل ظن رجحان كل واحد منهما على صاحبه من وجه دون وجه
فها هنا صور
إحداها أن يستويا في الدين ويتفاضلا في العلم فمنهم من خيره ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم وهو الأقرب لمزيته ولهذا يقدم في إمامة الصلاةوثانيتها أن يتساويا في العلم ويتفاضلا في الدين فها هنا وجب الأخذ بقول الأدين
وثالثها أن يكون أحدهما أرجح في علمه فقيل يؤخذ بقول الأدين والأقرب ترجيح قول الأعلم لأن الحكم مستفاد من علمه لا من ديانته
فإن قلت العامي ربما اغتر بالظواهر وقدم المفضول على الفاضل فإن جاز له أن يحكم بغير بصيرة في ترجيح بعض العلماء على بعض فليجز له أن يحكم في نفس المسألة بما يقع له ابتداء وإلا فأي فرق بين الأمرين
قلت من مرض له طفل وليس له طبيب فإن سقاه دواءا برأيه كان متعديا مقصرا ولو راجع طبيبا لم يكن مقصرا فإن كان في البلد طبيبان وقد اختلفا في الدواء فخالف الأفضل عد مقصرا
ثم أنه يعلم كون أحدهما أعلم من الآخر ب الأخبار وبإذعان المفضول له وبأمارات تفيد غلبة الظن فكذلك في حق العلماء يعلم الأفضل بالتسامع والقرائن دون البحث عن نفس العلم والعامي أهل له فلا ينبغي أن يخالف الظن بالتشهي
مسالة
الرجل الذي تنزل به الواقعة فإما أن يكون عاميا صرفا أو عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد أو عالما بلغ درجة الاجتهاد فإن كان عاميا صرفا حل له الاستفتاء
وإن كان عالما بلغ درجة الاجتهاد فإن كان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم فها هنا أجمعوا على أنه لا يجوز له أن يقلد مخالفه ويعمل بظن غيره أما إذا لم يجتهد فها هنا قد اختلفوا فذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يجوز للعالم تقليد العالم ألبتة وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثورى رحمهم الله بجوازه مطلقا
ومن الناس من فصل وذكر فيه وجوها
أحدها أنه يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصحابة ولا يجوز تقليد غيرهم وهو القول القديم للشافعي رضى الله نعه وثانيها أنه يجوز تقليد العالم للأعلم وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله
وثالثها أنه له التقليد فيما يخصه دون ما يفتى به
ورابعها أنه يجوز له التقليد فيما يخصه إذا كان بحيث لو اشتغل بالاجتهاد لفاته الوقت وهو قول ابن سريج
لنا وجهان
الأول أن هذا المجتهد أمر بالاعتبار في قوله تعالى فاعتبروا يا أولى الأبصار ولم يأت به فيكون تاركا للمأمور به فيكون عاصيا فيستحق النار ترك العمل به في حق العامي لعجزه عن الاجتهاد فيبقى معمولا به في حق المجتهد
الثاني أنه متمكن من الوصول إلى حكم المسألة بفكرته فوجب فوجب أن يحرم عليه التقليد كما في الأصول والجامع وجوب الاحتراز عن الضرر المحتمل عند القدرة على الاحتراز عنه
فإن قلت المعتبر في الأصول اليقين وأنه لا يحصل بالتقليد بخلاف الفروع فإن البغية فيها الظن ويمكن حصوله بالتقليد ولذلك جاز للعامي أن يقلد في الفروع دون الأصول
وأيضا فما ذكرتموه ينتقض بقضاء القاضي فإنه لا يجوز خلافه وإن كان متمكنا من معرفة الحكم فإنه لا معنى للتقليد إلا وجوب العمل عليه من غير حجة
وينتقض أيضا بمن دنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم
فإنه متمكن من الوصول إلى حكم المسألة مع أنه يجوز أن يسأل من أخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قلت أما الجواب عن الأول فهو أنا إنما أوجبنا على المكلف تحصيل اليقين لأنه قادر والدليل حاضر فوجب عليه تحصيله احترازا عن الخطأ المحتمل
وهذا المعنى حاصل في مسألتنا لأن المكلف قادر و الدليل المعين للظن الأقوى حاصل فوجب عليه تحصيله احترازا عن الخطأ المحتمل في الظن الضعيف
وعن الثاني أنه لما دلت الدلالة على أن الحكم الذي قضى به القاضي لا يمكنه نسخه بالاجتهاد فلم يكن العمل به تقليدا بل عملا بذلك الدليل
وعن الثالث أنه لا نسلم بجواز الاكتفاء بالسؤال من غير الرسول صلى الله عليه و سلم عند القدرة
واحتج المخالف بأمور
أحدها قوله تعالى فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والعالم قبل أن يجتهد لا يعلم فوجب أن يجوز له السؤالوثانيها قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والعلماء من أولي الأمر لأن أمرهم ينفذ على الأمراء والولاة
وثالثها قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين أوجب الحذر بانذار من تفقه في الدين مطلقا فوجب على العالم قبوله كما وجب على العامي ذلك
ورابعها إجماع الصحابة روي أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان
أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين فقال نعم وكان ذلك بمشهد من عظماء الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان ذلك إجماعا فإن قلت إن عليا خالف فيه قلت إنه لم ينكر جوازه لكنه لم يقبله ونحن لا نقول بوجوبه حتى يضرنا ذلك
وخامسها أنه حكم يسوغ فيه الاجتهاد فجاز لمن لم يكن عالما به تقليد من علمه كالعامي والجامع وجوب العمل بالظن الحاصل بقول المفتي
وسادسها أجمعنا على أنه يجوز للمجتهد أن يقبل خبر الواحد عن مجتهد آخر بل عن عامي وإنما جاز ذلك اعتمادا على عقله ودينه فها هنا إذا أخبر المجتهد عن منتهى اجتهاده بعد استفراغ الوسع
والطاقة فلأن يجوز العمل به كان أولى
وسابعها أن المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى العمل بفتوى مجتهد آخر فقد حصل ظن أن حكم الله تعالى ذلك وذلك يقتضى أن يحصل له ظن أنه لو لم يعمل به لا ستحق العقاب فوجب أن يجب العمل به دفعا للضرر المظنون
والجواب عن الأول أن ظاهر الآية يقتضي وجوب السؤال وإنه غير واجب
بالاتفاقوأيضا فقوله إن كنتم لا تعلمون يقتضي أن يجب على المجتهد بعد اجتهاده استفتاء غيره لأنه بعد اجتهاده ليس بعالم بل هو ظان وبالإجماع لا يجوز ذلك
وأيضا فإنه أمر بالسؤال وليس فيه تعيين ما عنه السؤال فنحن نحمله على السؤال عن وجه الدليل
وعن الثاني
أن الأصول دلت على وجوب الطاعة لكنهالا تدل على وجوب الطاعة في كل شيء فنحن نحملها على وجوب الطاعة في الأقضية والأحكام والدليل على أن الآية لا تتناول محل النزاع أنها لو تناولته لوجب ذلك التقليد وبالإجماع التقليد غير واجب
وعن الثالث
أن الآية تدل على وجوب الحذر عند إنذار لا عند كل إنذار ونحن نقول بالأول فإنا نوجب العمل بروايتهوعن الرابع
أنه يحتمل أن يكون المراد من سيرة الشيخين طريقتهما في العدل والإنصاف والانقياد للحق والبعد عن الدنياوعن الخامس
أن الفرق هو أن العامي قاصر فجاز له العمل بالتقليد والعالم ليس بقاصروعن السادس
أن المفتي ربما بنى اجتهاده على خبر واحد فإذا تمسك به المجتهد ابتداءا كان الاحتمال فيه أقل مما إذا قلد فيه غيرهوعن السابع
أن مجرد الظن واجب العمل به لكن إذا لم يقم دليل سمعييصرفنا عنه وما ذكرناه من الدلائل السمعية يوجب العدول عن هذا الظن
القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
مسألةلا يجوز التقليد في أصول الدين لا للمجتهد ولا للعوام وقال كثير من الفقهاء بجوازه
لنا
أن تحصيل العلم في أصول الدين واجب على الرسول صلى الله عليه و سلم فوجب أن يجب عليناوإنما قلنا أنه كان واجبا على الرسول صلى الله عليه و سلم لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله
وإنما قلنا إنه لما كان واجبا على الرسول صلى الله عليه و سلم وجب أيضا على أمته لقوله تعالى واتبعوه
فإن قيل لا نسلم أنه يمكن إيجاب العلم بالله تعالى وذلك لأن المأمور إن لم يكن عالما بالله تعالى فحالما لا يكون عالما بالله استحال أن يكون عالما بأمر الله تعالى وحالما يمتنع كونه عالما بأمر الله تعالى يمتنع كونه مأمورا من قبله وإلا لكان ذلك تكليف ما لا يطاق
وإن كان عالما بالله تعالى استحال أمره به لأن تحصيل الحاصل محال
سلمنا أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان مأمورا بذلك فلم قلت إنه يلزم من كون الرسول مأمورا كون الأمة مأمورين به
وما ذكرتم من الدليل معارض بأمور
أحدها أن الأعرابى الجلف العامي كان يحضر ويتلفظ بكلمتي الشهادة وكان الرسول عليه الصلاة و السلام يحكم بصحة إيمانه وما ذاك إلا التقليد وثانيها أن هذه الدلائل لا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد ممارسة شديدة وإنهم لم يمارسوا شيئا من هذا العلم فيمتنع اطلاعهم عليه وإذا كان كذلك تعين التقليد
وثالثها أنه عليه الصلاة و السلام لم يقل لأحد ممن تلفظ بكلمتي الشهادة هل علمت حدوث الأجسام وأنه تعالى مختار لا موجب فدل هذا على أن خطور هذه المسائل بالبال غير معتبر في الإيمان لا تقليدا ولا علما
ومنهم من عول في هذه المسألة على طريقة أخرى فقال اجمعت الأمة على أنه لا يجوز إلا تقليد المحق لكن لا يعلم أنه محق إلا إذا عرف بالدليل أن ما يقوله حق فإذن لا يجوز له أن يقلد إلا بعد أن يستدل ومتى صار مستدلا امتنع كونه مقلدا فيقال لهم هذا معارض بالتقليد في الشرعيات فإنه لا يجوز له تقليد المفتي إلا إذا كان المفتي قد أفتى بناءا على دليل شرعى
فإن قلت الظن فيه كاف فإن أخطأ كان ذلك الخطأ محطوطا عنه قلت فلم لا يجوز مثله في مسائل الأصول
واعلم أن في هذه المسألة ابحاثا دقيقة مذكورة في كتبنا الكلامية
والأولى في هذه المسألة أن يعتمد على وجه وهو أن يقال دل القرآن على ذم التقليد لكن ثبت جواز التقليد في الشرعيات فوجب صرف الذم إلى التقليد في الأصول
وإذ قد وفقنا الله تعالى بفضله حتى تكلمنا في جميع ابواب أصول الفقه فلنتكلم الآن فيما اختلف فيه المجتهدون أنه هل هو من أدلة الشرع أو ليس كذلك
الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع وفيه مسائل
المسألة الأولى في حكم الأفعال
اعلم أنا بينا في أول هذا الكتاب أنه لا حكم قبل الشرع وأجبنا عن شبه المخالفين ونريد الآن أن نبين أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع بأدلة الشرع فإن ذينك أصلان نافعان في الشرعأما الأصل الأول فالدليل عليه وجوه
المسلك الأول التمسك بقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا واللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع فإن قيل لا نسلم أن اللام تقتضى الاختصاص بجهة الانتفاع والدليل عليه قوله تعالى وإن أسأتم فلها لله ما في السماوات والأرض ففي هاتين الآيتين يمتنع أن تكون اللام للاختصاص بالمنافع ولأن النحاة قالوا اللام للتمليك وهو غير ما قلتموه
سلمنا ذلك ولكنه يفيد مسمى الانتفاع أو يفيد كل الانتفاعات
الأول مسلم ويكفى في العمل بها حصول فرد واحد الانتفاعات وهو الاستدلال بها على الصانع تعالى
والثاني ممنوع فما الدليل
سلمنا أنه يفيد كل الانتفاعات لكن بالخلق لأن اللام داخلة على الخلق فلم قلت إن المخلوق كذلك
سلمنا أنه يفيد الانتفاع بالمخلوق لكن لكل واحد في حال واحد لأن هذا مقابلة الجمع بالجمع فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد فقط
سلمنا أنه يفيد العموم لكن كلمة في للظرفية فيدل على إباحة كل ما في داخل الأرض وهو الركاز والمعادن فلم قلتم إن ما على الأرض كذلك
سلمنا إباحة كل ما على الأرض لكن في ابتداء الخلق لأن قوله خلق لكم يشعر بأنه حالما خلقتها إنما خلقها لنا فلم قلتم إنه بقي في الدوام كذلك فإن قلت الأصل في الثابت البقاء قلت هذا فيما يحتمل البقاء لكن كونه مباحا صفة والصفة لا تبقى
سلمنا الإباحة حدوثا وبقاءا لكن لمن كان موجودا وقت ورود هذا الخطاب لأن قوله تعالى خلق لكم خطاب مشافهة فيختص بالحاضرين
سلمنا أنه يدل على اختصاصها بنا لكن قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض ينافي ذلك
والجواب الدليل على أن اللام تفيد المنفعة قوله تعالى لها ما كسبت وعليها
ما اكتسبت وقال عليه الصلاة و السلام النظرة الأولى لك والثانية عليك وقال عليه الصلاة و السلام له غنمه وعليه غرمه
ويقال هذا الكلام لك وهذا عليك
غاية ما في الباب أنها جاءت في سائر المواضع لمطلق الاختصاص فنقول لو جعلناه حقيقة في الاختصاص النافع أمكن جعله مجازا في مسمى الاختصاص لأن مسمى الاختصاص جزء من الاختصاص النافع والجزء لازم للكل واللفظ الدال على الشيء يصح جعله مجازا عن لازمه
أما لو جعلناه حقيقة لمسمى الاختصاص لم يكن الاختصاص النافع لازما لأن الخاص لا يكون لازما للعام وإذا لم يوجد اللزوم
لم يجز جعله مجازا عنه
وأما قول النحاة اللام للتمليك فلم يريدوا أنها حقيقة للملك وإلا لبطل بقوله الجل للفرس بل مرادهم الاختصاص النافع وهو عين ما قلناه
قوله يكفي حصول فرد من أفراد الانتفاعات وهو الاستدلال بها على الصانع تعالى
قلنا لا يمكن حمل الآية على هذا النفع لأن هذا النفع حاصل لكل مكلف من نفسه فإن يمكنه الاستدلال بنفسه على الصانع وإذا حصل له هذا النفع من نفسه كان تحصيل هذا الجنس من النفع من غيره ممتنعا لأن تحصيل الحاصل محال
قوله اللام داخلة على الخلق فلم قلت المخلوق كذلك
قلنا الخلق هو المخلوق لقوله تعالى هذا خلق الله أى مخلوق الله
وبتقدير أن يكون الخلق غير المخلوق لكن لا نفع للمكلف في صفة الله تعالى فوجب أن يكون المراد ها هنا من الخلق المخلوق
قوله مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد
قلنا لا نسلم أن هذا مقابلة الجمع بالجمع بل هذا يجرى مجري تمليك الدار الواحدة لشخصين فكما أن ذلك يقتضي تعلق حق كل واحد منهما لا بجزء معين من الدار بل بجميع أجزاء الدار فكذا ها هنا
قوله كلمة في لا تتناول إلا ما كان في باطن الأرض
قلنا لا نسلم بدليل قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قوله هب أنه ثبت هذا الحكم في الابتداء فلم قلت إنه يدوم
قلنا لأن الأصل فيما يثبت بقاؤه
قوله هذا الاختصاص صفة فلا تقبل الدوام
قلنا لكن حكم الله تعالى صفة فهي واجبه الدوام
قوله هب أن هذا الحكم ثبت للمخاطبين بهذا الخطاب فلم قلت إنه يثبت في حقنا
قلنا لأن الله تعالى لما حكم بذلك في حقهم وقد حكم به الرسول أيضا في حقهم فوجب أن يكون قد حكم به أيضا في حقنا لقوله عليه الصلاة و السلام حكمي في الواحد حكمي في الجماعة قوله هذا معارض بقوله تعالى لله
ما في السماوات وما في الأرض
قلنا التعارض إنما يثبت أن لو ثبت في الموضعين بمعنى واحد وهو محال لأن الذي أثبتناه في حقنا هو الاختصاص النافع وذلك في حق الله تعالى محال فإذن لا تعارض بل ذلك الاختصاص ليست إلا بجهة الخلق والإيجاد
المسلك الثاني
قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزقأنكر الله تعالى على من حرم زينة الله فوجب أن لا تثبت حرمة زينة الله وإذا لم تثبت حرمة زينة الله امتنع ثبوت الحرمة في كل فرد من أفراد زينة الله لأن المطلق جزء من المقيد فلو ثبتت الحرمة في فرد من أفراد زينة الله تعالى لثبتت الحرمة في زينة الله تعالى وذلك على خلاف الأصل وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة
المسلك الثالث
أن الله تعالى قال أحل لكم الطيبات وليس المراد من الطيب الحلال وإلا لزم التكرار فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها
المسلك الرابع القياس
وهو أنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعا ولا على المنتفع ظاهرا فوجب أن لا يمنع كالاستضاءة ب ضوء سراج الغير والاستظلال بظل جدارهإنما قلنا إنه لا ضرر فيه على المالك لأن المالك هو الله تعالى والضرر عليه محال
وأما ملك العباد فقد كان معدوما والأصل بقاء ذلك العدم ترك العمل به فيما وقع اتفاق الخصم على كونه مانعا فيبقى في غيره على الأصل
فإن قيل فهذا يقتضي القول بإباحة كل المحرمات لأن فاعلها ينتفع بها ولا ضرر فيها على المالك ويقتضى سقوط التكاليف بأسرها ولا شك في فساده
وأيضا فالقياس على الاستضاءة والاستظلال غير جائز لأن المالك لو منع من الاستضاءة والاستظلال قبح ذلك منه والله تعالى لو منعه من الانتفاع لم يقبح
والجواب عن الأول أنا احترزنا عنه بقولنا ولا ضرر على المنتفع ظاهرا وها هنا في فعل ما نهى الله عنه ترك ما أمر به ضرر أما على قول المعتزلة فلأنه لولا اشتمال الفعل والترك على جهة لأجلها حصل النهي وإلا لما جاز ورود النهي
وأما عندنا فلأن الله تعالى لما توعدنا بالعقاب عليه كان مشتملا على الضرر فلم يكن واردا علينا
وعن الثاني أنه لا يجب أن يكون الفرع مساويا للأصل من كل الوجوه بل يكفي حصول المساواة فيه من الوجه المقصود
المسلك الخامس
وهو أن الله تعالى خلق الأعيان إما لا لحكمة أو لحكمة والأول باطل لقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ولأن الفعل الخالي عن الحكمة عبث والعبث لا يليق بالحكيم وأما إن كان خلقها لحكمة فتلك الحكمة إما عود النفع إليه أو إلينا
والأول محال لاستحالة الانتفاع عليه فتعين أنه تعالى إنما خلقها لينتفع بها المحتاجون وهذا يقتضي أن يكون المقصود من الخلق نفع المحتاج وإذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان
فإن منع منه فإنما يمنع لأنه بحيث يلزمه رجوع ضرر إلى محتاج
فإذا نهانا الله تعالى عن بعض الانتفاعات علمنا أنه تعالى إنما منعنا منها لعلمه باستلزامها للمضار إما في الحال أو في المآل ولكن ذلك على خلاف الأصل
فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة وهذا النوع من الكلام هو اللائق بطباع الفقهاء والقضاة
وإن كان تحقيق القول فيه لا يتم إلا مع القول بالاعتزال
أما الأصل الثاني وهو أن الأصل في المضار الحرمة فهذا يستدعي بحثين
أحدهما البحث عن ماهية الضرر
والثاني إقامة الدليل على حرمته
أما الأول فقد قالوا الضرر ألم القلب لأن الضرب يسمى ضررا وتفويت منفعة الإنسان يسمى إضرارا والشتم والاستخفاف يسمى ضررا ولا بد من جعل اللفظ اسما لمعنى مشترك بين هذه الصور دفعا للاشتراك وألم القلب معنى مشترك فوجب جعل اللفظ حقيقة فيه فان قيل أتعني بألم القلب الغم والحزن أم شيئا آخر
الأول باطل لأن من خرق ثوب إنسان أو خرب داره وكان المالك غافلا عن هذه الحالة يقال أضربه مع أنه لم يوجد الغم والحزن وإن عنيت به شيئا آخر فبينه نزلنا عن الاستفسار فلم قلت الضرر ألم القلب
قوله لا بد من معنى مشترك في مواضع الاستعمال
قلنا هذا مسلم لكن لم قلت إنه لا مشترك إلا ألم القلب بل ها هنا مشترك آخر وهو تفويت النفع فما الدليل على أن ما ذكرتموه أولى
ثم الذي يدل على أن ما ذكرناه أولى أن النفع مقابل الضرر والنفع تحصيل المنفعة فوجب أن يكون الضرر إزالة المنفعة وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يكون حقيقة فيما ذكرتموه دفعا للاشتراك
سلنا أن ما ذكرتموه يدل على أن الضرر ألم القلب لكنه معارض بوجهين
الأول أن من خرب دار إنسان وكان المالك غافلا عنه يقال أضربه مع أنه لم يوجد هناك ألم القلب لأن ألم القلب لا يحصل إلا بعد الشعور بهالثاني قوله تعالى قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئا ولا يضركم أخبر أن عبادة الأصنام لا تضرهم مع أنها تؤلم قلوبهم يوم القيامة لأنهم يعاقبون بذلك
فثبت أن الضرر ليس ألم القلب
والجواب أن القلب إذا ناله غم وحزن انعصر دم القلب في الباطن وانعصار دم القلب في الباطن إنما يكون لانعصار القلب في نفسه وانعصار العضو مؤلم له لأن أي عضو عصرته فإنه يحصل منه ألم فالمراد من ألم القلب تلك الحالة الحاصلة له عند ذلك الانعصار فظهر بهذا أن ألم القلب مغاير للغم وإن كان مقارنا له وغير منفك عنه
وأما من خرق ثوب إنسان فإنما يقال أضربه على معنى أنه أوجد ما لو عرفه لحصل الضرر لا محالة وهو في الحقيقة إطلاق اسم المسبب على السبب مجازا
قوله لم قلت لا مشترك سواه
قلنا لأن المشترك الآخر كان معدوما والأصل بقاؤه على
العدم
قوله تفويت النفع أيضا مشترك
قلنا لا يجوز جعله مسمى الضرر لأن البيع والهبة حصل فيهما تفويت النفع لأن البائع فوت على نفسه الانتفاع بعين المبيع مع أن ذلك لا يسمى ضررا
قوله الضرر في مقابلة النفع
قلنا هب أنه كذلك لكن النفع عبارة عن تحصيل اللذة أو ما يكون وسيلة إليها والضرر عبارة عن تحصيل الألم أو ما يكون وسيلة إليه
وأما الآية فنقول لا نسلم أن الأصنام تضرهم في الدنيا ولا في الآخرة بل الذي يضرهم في الآخرة عبادتها فزال السؤال
المقام الثاني في إقامة الدلالة على حرمة الضرر والمعتمد فيه قوله عليه الصلاة و السلام لا ضرر ولا إضرار في الإسلام
والكلام على التمسك بهذا النص اعتراضا وجوابا مشهور في الخلافيات
المسألة الثانية في استصحاب الحال
المختار عندنا أنه حجة وهو قول المزني وأبي بكر الصيرفي من فقهائنا خلافا للجمهور من الحنفية والمتكلمينلنا
أن العلم بتحقيق أمر في الحال يقتضى ظن بقائه في في الاستقبال والعمل بالظن واجب ولا معنى لكونه حجة إلا ذلكإنما قلنا إن العلم بتحقيق أمر في الحال يقتضى ظن بقائه في الاستقبال لأن الباقي مستغن عن المؤثر والحادث مفتقر إليه والمستغني عن المؤثر راجح الوجود بالنسبة إلى المفتقر إليه
إن قلنا أن الباقي مستغن عن المؤثر لأنا لو فرضنا له مؤثرا فذلك المؤثر إما أن يقال إنه صدر عنه أثر أو ما صدر عنه أثر
والثاني محال لأن فرض المؤثر بدون الأثر متناقض وأما الأول فأثره إما أن يكون شيئا ما كان موجودا
أو كان موجودا
فإن قلنا إنه ما كان موجودا كان الأثر حادثا لا باقيا
وإن قلنا إنه كان موجودا كان ذلك تحصيلا للحاصل وهو محال فثبت أن الباقي مستغن عن المؤثر
وإنما قلنا إن الحادث مفتقر إليه لأن إجماع المسلمين بل إجماع جمهور العقلاء منعقد عليه والاستقصاء فيه مذكور في كتابنا المسمى ب الخلق والبعث
وإنما قلنا إن المستغنى عن المؤثر راجح بالنسبة إلى المفتقر إليه لوجهين
الأول وهو أن المستغنى عن المؤثر لا بد أن يكون الوجود به أولى إذ لو كان الوجود مساويا للعدم لاستحال الرجحان إلا
بمنفصل وكان يلزم افتقاره إلى المؤثر لكنا فرضناه مستغنيا عنه هذا خلف فإذن وجود الباقي راجح على عدمه
وأما الحادث فليس أحد طرفيه راجحا على الآخر إذ لو كان راجحا لاستحال افتقاره إلى المرجح وإلا لكان ذلك المرجح مرجحا لما هو في نفسه مترجح فكان ذلك تحصيلا للحاصل وهو محال
فثبت أن الباقي أولى بالوجود وأن الحادث ليس أولى بالوجود ولا معنى لظن وجوده إلا اعتقاد أن وجوده أولى فثبت أن الباقي راجح الوجود بالنسبة إلى الحادث
الثاني وهو أن الباقي لا يعدم إلا عند وجود المانع والمتقر إلى المؤثر كما يعدم عند وجود المانع فقد يعدم أيضا عند عدم المقتضي وما لا يعدم إلا بطريق واحد يكون أولى بالوجود مما يعدم بطريقين ولا معنى للظن إلا اعتقاد أنه أولى بالوجود
وإنما قلنا إن العمل بالظن واجب لقوله عليه
الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر ولأنه لو لم يجب لزم جواز ترجيح المرجوح على الراجح وإنه غير جائز في بديهة العقل
ولأن العمل بالقياس وخبر الواحد والشهادة والفتوى وسائر الظنون المعتبرة إنما وجب ترجيحا للأقوى على الأضعف وهذا المعنى قائم ها هنا فيلزم ثبوت الحكم ها هنا أيضا وهو وجوب العمل به
فإن قيل لا نسلم أن العلم بتحقق أمر في الحال يقتضي ظن بقائه في الاستقبال
قوله لأن الباقي مستغن عن المؤثر
قلنا ما المعنى بقولكم الباقي مستغن عن المؤثر إن عنيتم به أن كونه باقيا مستغن عن المؤثر فهذا ممنوع
وأيضا فهو مناقض لقولكم الحادث مفتقر إلى المؤثر لأن كونه باقيا لم يكن حاصلا حال حدوثه ثم حصل بعد أن لم يكن فيكون حادثا وأنتم قد اعترفتم أن الحادث لا بد له من مؤثر
وإن عنيتم بقولكم الباقي مستغن عن المؤثر شيئا آخر فبينوه لننظر فيه نزلنا عن الاستفسار فلم لا يجوز أن يقال الباقي له مؤثر ولذلك المؤثر أثر
قوله ذلك الأثر إما أن يكون شيئا ما كان حاصلا أو كان حاصلا
قلنا لم لا يجوز أن يقال ما كان حاصلا وذلك لأنه لا معنى لبقائه إلا حصوله في هذا الزمان بعد أن كان حاصلا في زمان آخر قبله لكن حصوله في هذا الزمان ما كان حاصلا قبل حصول هذا الزمان فإذن كونه باقيا أمر حادث فأثر المبقي هو ذلك الأثر
فإن قلت فعلى هذا التقدير يكون أثر المبقي أمرا حادثا فلا يكون مبقيا بل محدثا
قلت مرادنا من قولنا الباقي يفتقر إلى المبقى أن حصوله في الزمان الثاني لا بد فيه من شيء آخر وقد ثبت أنه لا يكون باقيا ما لم يحصل في الزمان الثاني وحصوله في الزمان الثاني مفتقر إلى مؤثر فإذن يمتنع أن يصدق عليه كونه باقيا إلا لمؤثر
فيعد ذلك البحث عن الواقع بذلك المؤثر وكونه أمرا مستمرا أو جديدا بحثا عن شيء خارج عن المقصود سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن يقال أثره شيء كان حاصلا
قوله تحصيل الحاصل محال
قلنا إن عنيت بتحصيل الحاصل أن يجعل عين الشيء الذي كان موجودا في الزمان الأول حادثا في الزمان الثاني فلا نزاع في أن ذلك محال لكن لم قلت إن إسناد الباقي إلى المؤثر يوجب ذلك
وإن عنيت به أن الوجود الذي صدق عليه في الزمان الأول أنه إنما ترجح لهذا المؤثر صدق عليه في الزمان الثاني أيضا أنه ترجح لهذا المؤثر فلم قلت إن ذلك محال
سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على استغناء الشيء حال بقائه عن المؤثر لكن ها هنا ما يعارضه وذلك لأن هذا الباقي كان بقاؤه ممكنا وكل ممكن فله مؤثر فالباقي حال بقائه له مؤثر
وإنما قلنا أنه ممكن لأنه في زمان حدوثه ممكن وإلا لم يفتقر إلى المؤثر وإمكانه من لوازم ماهيته وما كان من لوازم الماهية فهو واجب الحصول في جميع زمان تحقق الماهية فكان الإمكان حاصلا في زمان البقاء
وإنما قلنا إن الممكن مفتقر إلى المؤثر لأن الممكن قد استوى طرفاه وما كان كذلك افتقر إلى المرجح
فإن قلت لم لا يجوز أن يقال الإمكان إنما يحوج إلى المقتضى بشرط الحدوث وهذا الشرط فائت في زمان البقاء فلا يتحقق الافتقار
قلت لا يجوز جعل الحدوث مؤثرا في تحقق الاحتياج لأن الحدوث عبارة عن مسبوقية وجود الشيء بالعدم ومسبوقية الوجود بالعدم صفة ونعت له وصفة الشيء متوقفة على الشيء فالحدوث متوقف على الوجود المتأخر عن تأثير المؤثر فيه المتأخر عن احتياج المؤثر إليه المتأخر عن علة احتياجه إليه فلو كان الحدوث مؤثرا في ذلك الاحتياج إما بأن يكون علة أو جزء علة أو شرط علة لزم الدور وهو محال
سلمنا استغناء الباقي عن المؤثر وافتقار الحادث إليه فلم قلت إن المستغني راجح عن المفتقر
قوله في الوجه الأول أن الباقي أولى بالوجود والحادث ليس أولى ولا معنى للظن إلا اعتقاد أنه أولى
قلنا إن عنيت بهذه الأولوية أن العدم عليه ممتنع فهذا باطل لأن هذا الباقي يقبل العدم وإن عنيت به أمرا آخر فلا بد من بيانه
فإن قلت المراد منها درجة متوسطة بين الاستواء الذي هو مسمى الإمكان والتعيين المانع من النقيض الذي هو مسمى الضرر
قلت هذا محال لأن مع ذلك القدر من الأولوية إن امتنع النقيض فهو الضرروة وقد فرضنا أنه ليس كذلك
وإن لم يمتنع فمع ذلك القدر من الأولوية يصح عليه الوجود تارة والعدم أخرى فحصول أحدهما بدلا عن الآخر إن توقف على انضمام قيد إليه لم يكن الحاصل قبله كافيا في تحقق الأولوية
وإن لم يتوقف كانت نسبة ذلك القدر من الأولوية إلى طرفي الوجود والعدم على السوية فترجيح أحدهما على الآخر
لا لمرجح زائد يكون ترجيحا لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال
وأما الوجه الثاني فغاية ما في الباب أنه يمكن تحقق عدم الحادث بطريقتين ولا يمكن تحقق عدم الباقي إلا بطريق واحد فلم قلت إن هذا القدر يقتضي أن يكون الباقي راجحا في الوجود على الحادث سلمنا أن ما ذكرتموه يقتضي رجحان الباقي على الحادث من ذلك الوجه لكنه يقتضي عدم الرجحان من وجه آخر
بيانه أن الباقي لا يصدق عليه كونه باقيا إلا إذا حصل في الزمان الثاني فحصوله في الزمان الثاني أمر حادث فإذا لم يكن وجود الحادث راجحا فالمتوقف على ما لا يكون راجح الوجود لم يكن هو أيضا راجح الوجود فيلزم أن لا يكون الباقي راجح الوجود
سلمنا أن الباقي راجح الوجود ولكن ما لم يتحقق كونه باقيا
لا يتحقق كونه راجح الوجود وهو إنما يصدق عليه كونه باقيا إذا حصل في الزمان الثاني
فالحاصل أنا ما لم نعرف وجوده في الزمان الثاني لا نعرف كونه راجح الوجود وأنتم جعلتم رجحان وجوده دليلا على وجوده في الزمان الثاني فيكون دورا
سلمنا أن الباقي راجح في الوجود الخارجي على الحادث فلم قلت يجب أن يكون راجحا عليه في الظن لا بد لهذا من دليل
سلمنا حصول هذا الظن وأن العمل به واجب ولكنه معارض بدليل آخر يمنع من التمسك بالاستصحاب وهو أن من سوى بين الوقتين في الحكم فإما أن يقال إنما سوى بينهما لاشتراكهما فيما يقتضى ذلك الحكم أو ليس الأمر كذلك
فإن كان الأول فهو قياس وإن كان الثاني كان ذلك تسوية بين الوقتين في الحكم من غير دليل وإنه باطل بالإجماع
والجواب
قوله ما المراد من قولكم الباقي مستغن عن المؤثرقلنا لا شك في أن الباقي هو الذي حصل في زمان
بعد أن كان بعينه حاصلا في زمان آخر قبله
وهذا يقتضى أن تكون الذات الحاصلة في هذا الزمان عين الذات الحاصلة في ذلك الزمان الآخر
إذا ثبت هذا فنقول
هذه الذات التي صدق عليها أنها حصلت بعينها في الزمانين إما أن يقال حصل فيها في الزمان الثاني أمر لم يكن حاصلا في الزمان الأول أو لم يحصلفإن كان الأول كان الأمر المتجدد مغايرا للذات الباقية فيكون الباقي في الحقيقة هو الذات لا هذه الكيفية المتجددة فنحن ندعي أن ذلك الشيء الذي هو الباقي يستحيل إسناده إلى المؤثر حال بقائه
وعلى هذا التقدير لا يكون إسناد تلك الكيفية المتجددة قادحا في قولنا الباقي غير مستند إلى المؤثر لأن أحدهما غير الآخر
وإن قلنا إنه لم يحدث في الزمان الثاني أمر متجدد بل الحاصل في الزمان الثاني ليس إلا الذات التي كانت حاصلة في الزمان الأول فعلى هذا التقدير بطل قولهم إن كونه باقيا كيفية حادثة وأنها مفتقرة إلى المؤثر
فثبت أن على التقديرين السؤال ساقط
قوله حصوله في الزمان الثاني كيفية زائدة على الذات وهي مفتقرة إلى المؤثر
قلنا هذا باطل وبتقدير ثبوته فهو غير قادح في دليلنا
أما أنه باطل فلأن حصوله في الزمان الثاني لو كان كيفية زائدة على الذات لكان حصول ذلك الزائد في ذلك الزمان كيفية أخرى فلزم التسلسل وهو محال
ولأن العدم قد يصدق عليه أنه باق فلو كان تحققه في الزمان الثاني كيفية ثبوتية لزم قيام الصفة الموجودة بالموصوف الذي هو نفى محض وإنه محال
وأما أن بتقدير ثبوته فالمقصود حاصل فذلك لأن حصوله في الزمان الثاني لما كان أمرا حادثا كان إسناده إلى المؤثر إسنادا للحادث إلى المؤثر لا إسنادا للباقي
وكلامنا ليس إلا في الباقي
قوله ما الذي تعني بتحصيل الحاصل
قلنا نعني به أن الشيء الذي حكم العقل عليه بأنه كان حاصلا قبل ذلك يحكم عليه بأن حصوله الآن لأجل هذا الشيء
وهذا محال بالبديهة لأنه لما كان حاصلا قبل ذلك فلو أعطاه الآن هذا المؤثر حصولا لكان قد حصل نفس ما كان حاصلا وأنه محال
قوله الباقي حال بقائه ممكن والممكن مفتقر
قلنا لا نسلم أن الممكن إنما يفتقر إلى المؤثر بشرط كونه حادثا
قوله الحدوث متأخر
قلنا لا نريد به أن كونه حادثا شرط للافتقار بل نريد به أن كونه بحيث لو وقع بالمؤثر لكان حادثا بشرط افتقار الأثر إلى المؤثر وكونه بهذه الصفة أمر متقدم
قوله ما المراد من الأولوية
قلنا درجة متوسطة بين التساوي والتعيين المانع من النقيض
قوله هذا محال لأنه يقتضي ترجيح أحد المتساويين على الآخر لا لمرجح
قلنا لا نسلم أن ذلك ممتنع مطلقا بل ذلك إنما يمتنع بشرط الحدوث
قوله على الوجه الثاني لم قلت إنه لما أمكن حصول عدم الحادث بطريقين وعدم الباقي لا يحصل إلا بطريق كان وجود الحادث مرجوحا
قلنا لأن عدم حصول الحادث أكثر من عدم الباقي لأنه يصدق على ما لا نهاية له أنه لم يحدث
وأما عدم الباقي بعد حدوثه فمشروط بوجوده فإذا كان الوجود متناهيا كان العدم بعد الوجود متناهيا
وإذا كان عدم حدوث الحادث أكثر من عدم الباقي بعد وجوده والكثرة موجبة للظن ثبت أن عدم حدوث الحادث غالب على عدم الشيء ولا معنى للظن إلا ذلك واعلم أنه يمكن الاستدلال بهذه النكتة ابتداءا
قوله كونه باقيا يتوقف على حدوث حصوله في الزمان الثاني فكونه باقيا يتوقف على الحدوث الذي ليس براجح والموقوف على ما لا يكون راجحا ليس براجح
قلنا هذا إنما يلزم لو كان حصوله في الزمان الثاني كيفية وجودية وقد دللنا على أن ذلك محال لأنه يوجب التسلسل
ثم إن سلمنا صحة ذلك لكنا نقول لما ثبت أن الحدوث مرجوح فالذات إذا كانت حادثة فهناك أمران حادثان أحدهما الذات والآخر حصول الذات في ذلك الزمان
وأما إذا كانت الذات باقية والحادث أمر واحد وهو حصوله في ذلك الزمان أما الذات فهي ليست ب حادثة في نفسها
فإذن الحادث مرجوح من وجهين والباقي من وجه واحد فوجب أن يكون الباقي راجحا على الحادث من هذا الوجه قوله ما لم يعرف كونه باقيا لا يثبت رجحانه
قلنا لا حاجة إلى ذلك بل نقول هذا الذي وجد لا يمتنع عقلا أن يوجد في الزمان الثاني وأن يعدم لكن احتمال الوجود راجح على احتمال العدم من الوجه الذي ذكرناه فالعلم بوجوده في الحال يقتضي اعتقاد رجحان وجوده على عدمه في ثاني الحال فإذن العلم بالأولوية مستفاد من العلم بوجوده في الحال وعلى هذا التقدير يسقط الدور
قوله هب أن الباقي راجح على الحادث في الوجود الخارجي فلم قلت يجب أن يكون راجحا عليه في الذهن
قلنا لأن الاعتبار الذهنى مطابق للاعتبار الخارجي وإلا كان جهلا
قوله التسوية بين الزمانين إن لم تكن بالقياس كان ذلك تسوية بين الزمانين من غير دليل
قلنا القياس دليل واحد من أدلة الشرع وليس يلزم من عدم دليل معين عدم الدليل بالكلية بل نحن سوينا بين الزمانين في الحكم بناءا على ما ذكرنا من أن العلم بثبوته في في الحال يقتضي ظن ثبوته على ذلك الوجه في الزمان الثاني والعمل بالظن واجب
واعلم أن القول باستصحاب الحال أمر لا بد منه في الدين والشرع والعرف
أما في الدين فلأنه لا يتم الدين إلا بالاعتراف بالنبوة ولا سبيل إليه إلا بواسطة المعجزة ولا معنى للمعجزة
إلا فعل خارق للعادة ولا يحصل فعل خارق للعادة إلا عند تقرر العادة ولا معنى للعادة إلا أن العلم بوقوعه على وجه مخصوص في الحال يقتضي اعتقاد أنه لو وقع لما وقع إلا على ذلك الوجه وهذا عين الاستصحاب
وأما في الشرع فلأنا إذا عرفنا أن الشرع تعبدنا بالإجماع أو بالقياس أو بحكم من الأحكام فلا يمكننا العمل به إلا إذا علمنا أو ظننا عدم طريان الناسخ
فإن علمنا ذلك بلفظ آخر افتقرنا فيه إلى اعتقاد عدم النسخ أيضا فإن كان ذلك بلفظ آخر أيضا تسلسل إلى غير النهاية وهو محال فلا بد أن ينتهي آخر الأمر إلى التمسك ب الاستصحاب وهو أن علمنا بثبوته في الحال يقتضي ظن وجوده في الزمان الثاني
وأيضا فالفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أنا متى يتقنا حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل أخذنا بالمتيقن وهذا عين الاستصحاب لأنهم رجحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث
وأما العرف فلأن من خرج من داره وترك أولاده فيها
على حالة مخصوصة كان اعتقاده لبقائهم على تلك الحالة التي تركتهم عليها راجحا على اعتقاده لتغير تلك الحالة
ومن غاب عن بلده فإنه يكتب إلى أحبابه وأصدقائه عادة في الأمور التي كانت موجودة حال حضوره وما ذاك إلا ل أن اعتقاده في بقاء تلك الأمور راجح على اعتقاده في تغيرها بل لو تأملنا لقطعنا بأن أكثر مصالح العالم ومعاملات الخلق مبني على القول بالاستصحاب
فرع
من قال النافي لا دليل عليه إن أراد أن العلم بذلك العدم الأصلي يوجب ظن دوامه في المستقبل فهذا حق كما بيناهوإن أراد به غيره فهو باطل لأن العلم بالنفي أو
الظن به لا يحصل إلا لمؤثر
المسألة الثالثة في الاستحسان
المحكي عن الحنفية القول بالاستحسان ومخالفوهم أنكروا ذلك عليهم لظنهم أنها يعنون به الحكم من غير دليل والذي حصله المتأخرون في تحديده وجهان
الأول قال الكرخي الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول وهذا يلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص وعن المنسوخ إلى الناسخ استحسانا
الثاني قال أبو الحسين الاستحسان ترك وجه من وجوه الاجتهاد
غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطارىء على الأول
قال ولا يلزم عليه العدول عن العموم إلى القياس المخصص لأن العموم لفظ شامل ولا يلزم عليه أن يكون أقوى القياس استحسانا لأن الأقوى ليس في حكم الطارىء على الأضعف فإن كان طارئا فهو استحسان
فإن قلت فقد قال محمد بن الحسن في غير موضع من كتبه تركنا الاستحسان للقياس كما لو قرأ آية ال سجدة في آخر السورة فالقياس يقتضي أن يجتزىء بالركوع والاستحسان أن لا يجتزىء به بل يسجد لها ثم إنه قال بالقياس فهذا الاستحسان إن كان أقوى من القياس فكيف تركه وإن لم يكن أقوى منه فقد بطل حدكم
قلت ذلك المتروك إنما يسمى استحسانا لأنه وإن كان
الاستحسان وحده أقوى من القياس وحده لكن اتصل بالقياس شيء آخر صار ذلك المجموع أقوى من الاستحسان كما في المسألة التي ذكرتموها فإن الله تعالى أقام الركوع مقام السجود في قوله تعالى وخر راكعا وأناب فهذا تقرير هذا الحد الذي ذكره أبو الحسين رحمه الله
واعلم أن هذا يقتضي أن تكون الشريعة كلها استحسانا لأن مقتضى العقل هو البراءة الأصلية وإنما يترك ذلك لدليل أقوى منه وهو نص أو إجماع أو قياس
وهذا الأقوى في حكم الطارىء الأول فيلزم أن يكون الكل استحسانا وهم لا يقولون به لأنهم يقولون تركنا القياس للاستحسان وهذا يقتضى أن يكون القياس مغايرا للاستحسان فالواجب أن يزاد في الحد قيد آخر فيقال ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة الأصلية والعمومات اللفظية لوجه أقوى منه وهو في حكم الطارىء على الأول إذا عرفت هذا فنقول اتفق أصحابنا على إنكار الاستحسان
وهذا الخلاف إما أن يكون في اللفظ أو في المعنى لا يجوز أن يكون في اللفظ لأنه قد ورد في القرآن والسنة وألفاظ سائر المجتهدين هذه اللفظة
أما القرآن فقوله تعالى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وقوله فيتبعون
أحسنه
وأما السنة فقوله عليه الصلاة و السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا
وأما ألفاظ سائر المجتهدين فلأن الشافعي رضي الله عنه قال في باب المتعة أستحسن أن تكون ثلاثين درهما
وفي باب الشفعة أستحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام وقال في المكاتب أستحسن أن يترك عليه شيء فثبت بهذا أن الخلاف ليس في اللفظ
وإنما الخلاف في المعنى وهو أن القياس إذا كان قائما في صورة الاستحسان في سائر الصور ثم ترك العمل به في صورة الاستحسان وبقي معمولا به في غير تلك الصورة فهذا هو القول بتخصيص العلة وهو عند الشافعي وجمهور المحققين باطل وقد تقدمت هذه المسألة فظهر أن القول بالاستحسان باطل
المسألة الرابعة
الحق أن قول الصحابى ليس بحجة وقال قوم إنه حجة مطلقا ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوهاأحدها أنه حجة إن خالف القياس
وثانيها أن قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة فقط
وثالثها أن قول الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا حجة
لنا النص والإجماع والقياس
أما النص فقوله تعالى فاعتبروا يا أولى الأبصار أمر بالاعتبار وذلك ينافي جواز التقليد
وأما الإجماع فهو أن الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما ولا كل واحد منهما على صاحبه فيما فيه اختلفا
وأما القياس فهو أنه متمكن من إدراك الحكم بطريقة فوجب أن يحرم عليه التقليد كما في الأصول
واحتج المخالف بوجوه
أحدها قوله عليه الصلاة السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم جعل الاهتداء لازما للاقتداء بأي واحد كان منهم وذلك يقتضي أن يكون قوله حجةوثانيها إن لم يجز اتباع كل واحد منهم فيجب اتباع أبي بكر
وعمر رضي الله عنهما للخبر والإجماع
أما الخبر فقوله عليه الصلاة و السلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر
وأما الإجماع فقد ولى عبد الرحمن عثمان الخلافة بشرط الاقتداء بسيرة الشيخين فقبل ولم ينكر ذلك على عثمان وكان ذلك بمحضر من أكابر الصحابة فكان إجماعا
وثالثها إن لم يجب اتباع أبي بكر وعمر وحدهما وجب اتباع الخلفاء الأربعة لقوله عليه الصلاة و السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وقوله عليكم للإيجاب وهو عام
ورابعها أن الصحابي إذا قال ما يخالف القياس فلا محمل له إلا أنه اتبع الخبر
والجواب عن الأول أن قوله عليه الصلاة و السلام بأيهم اقتديتم اهتديتم خطاب مشافهة فلعل ذلك كان خطابا للعوام
وعن الثاني أن السنة هي الطريقة وهي عبارة عن الأمر الذي يواظب الإنسان عليه فلا تتناول ما يقوله الإنسان مرة واحدة
وعن الثالث أنا نقول بموجبه فيجوز الاقتداء بهما في تجويزهما لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد
وأيضا فلو اختلفا كما اختلفا في التسوية في العطاء فأيهما يتبع
وعن الإجماع أن قول عثمان معارض بقول علي رضي الله عنهما
وعن الرابع أن الصحابي لعله قال بما يخالف القياس لنص ظنه دليلا مع أنه في الحقيقة ما كان دليلا
نعم لو تعارض قياسان والصحابي مع أحدهما فيجوز الترجيح بقول الصحابي فأما جعله حجة فلا
فرعان
الأول اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في تقليد الصحابي فقال في القديم يجوز تقليده إذا قال قولا وانتشر ولم يخالف وقال في موضع آخر يقلد وإن لم ينتشر وقال في الجديد لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد عالما آخر
وهو الحق المختار لأن الدلائل المذكورة مطردة في الكل فإن قلت كيف لا نفرق بينهم وبين غيرهم مع ثناء الله تعالى وثناء رسوله صلى الله عليه و سلم عليهم حيث قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين وقال السابقون الأولون من المهاجرين إلى قوله رضي الله عنهم وقال عليه الصلاة و السلام خير القرون قرني
قلت هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقاد فيهم ولا
يوجب تقليدهم بدليل أنه ورد أمثالها في حق آحاد الصحابة مع إجماع الصحابة على جواز مخالفتهم
قال عليه الصلاة و السلام لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح
وقال إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقال والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك
وقال في حق علي اللهم أدر الحق مع علي حيث دار
وقال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد وقال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما على شيء ما خالفتكما وكل ذلك ثناء لا يوجب الاقتداء
الثاني في تفاريع القول القديم للشافعي رضي الله عنه وهي سبعة
أحدها قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب اختلاف الحديث روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات وفي كل ركعة ست سجدات قال لو ثبت ذلك عن علي لقلت به فإنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفا
وثانيها قال في موضع قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف فهو حجة قال الغزالي رحمه الله وهو ضعيف لأن السكوت ليس بقول فأي فرق بين أن ينتشر أو لا ينتشر والعجب من الغزالي أنه تمسك بمثل هذا الإجماع على أن خبر الواحد حجة والقياس حجة
وثالثها نص الشافعي رضي الله عنه على أنه إذا اختلفت الصحابة فالأئمة الأربعة أولى فإن اختلف الأئمة فقول أبي بكر وعمر أولى وكل ذلك للأحاديث المذكورة
ورابعها نص في موضع آخر أنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسا لأن زيادة علمه تقوي اجتهاده وتبعده عن التقصير
وخامسها إن اختلف الحكم والفتوى عن الصحابة فقد اختلف قول الشافعي رضى الله عنه فقال مرة الحكم أولى لأن العناية به أشد وقال مرة الفتوى أولى لأن سكوتهم عن الحكم محمول على الطاعة
وسادسها هل يجوز ترجيح أحد القياسين بقول الصحابي
والحق أنه في محل الاجتهاد فربما يتعارض ظنان والصحابي في أحد الجانبين فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابي ويكون ذلك اغلب على ظنه
وسابعها إذا حمل الصحابي لفظ الخبر على أحد معنييه منهم من جعله ترجيحا
وقال القاضي أبو بكر إذا لم يقل علمت ذلك من قصد رسول الله صلى الله عليه و سلم بقرينة شاهدتها لم يكن ذلك ترجيحا
المسألة الخامسة
اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه و سلم أو للعالم احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب فقطع بوقوعه مويس بن عمران وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه
وتوقف الشافعي رضي الله عنه في امتناعه وجوازه وهو المختار وصحة هذا التوقف لا تظهر إلا بالاعتراض على أدلة القاطعين
أما المانعون ففقد تعلقوا تارة بما يدل على امتناع وقوعه وأخرى بما يدل على عدم وقوعه
أما الوجه الأول فتقريره أن من أجاز هذا التكليف إما أن يجعل الاختيار مما تتم به المصلحة أو يجعل الفعل مصلحة في نفسه ثم يختاره المكلف
والأول باطل لوجهين
أحدهما أن على هذا التقدير يسقط التكليف لأن المكلف متى قال إن اخترته فافعله وإن لم تختره فلا تفعله فهذا محض إباحةوثانيهما أن المكلف لا ينفك عن الفعل والترك ولا يجوز تكليف المرء
بما لا يمكنه الإنفكاك عنه بخلاف التخيير في الكفارات الثلاث فإنه يمكنه الانفكاك عنها أجمع
وأما الثاني فهو باطل من وجوه أربعة
أولها أنه إما أن يجوز له الحكم على هذا الوجه في الحوادث الكثيرة أو في الحادثة والحادثتين
والأول محال لأنه يمتنع حصول الإصابة بالاتفاق في الأشياء الكثيرة ولهذا لا يجوز أن يقال للأمي اكتب مصحفا فإنك لا تخط بيمينك إلا ما يطابق ترتيب القرآن وللجاهل أخبر فإنك لا تخبر إلا بالصدق ولولا ما ذكرناه لبطلت دلالة الفعل المحكم على علم فاعله وبطلت دلالة أخبار الغيب على النبوة
وأما الوجه الثاني وهو أن يجوز ذلك في القليل دون الكثير فهو باطل لأن كل من جوزه في القليل جوزه في الكثير ومن منع منه في الكثير منع منه في القليل فالقول بالفرق خرق للإجماع
وثانيها وهو أنه إنما يحسن القصد إلى الفعل إذا علم أو ظن كونه حسنا فلا بد وأن يتميز له الحسن من القبح قبل الإقدام على الفعل فإذا لم تتقدم هذه الأمارة المميزة كان التكليف باختيار الحسن دون القبيح تكليفا بما لا يطاق
فإن قلت إنما يميز بين الحسن والقبيح بأن يقال له قد علمنا بأنك لا تختار شيئا إلا وهو حسن
قلت فهذا يقتضي أنه إنما يعلم حسنه بعد فعله له وهو إذا فعله زال التكليف عنه
فالحاصل أن التمييز بين الحسن والقبيح لا بد وأن يكون متقدما على الاختيار وإلا وقع التكليف بما لا يطاق
وإذا قال الله تعالى إنك لا تحكم إلا بالصواب فها هنا التمييز بين الحسن والقبيح لا يحصل إلا بعد الفعل والشيء الذي يجب أن يكون متقدما ليس هو الذي يجب أن يكون متأخرا
وثالثها لو جاز أن يقول له احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب
لجاز أن يكلفه تصديق النبي وتكذيب المتنبي من غير دليل ألبتة بل يكله فيه إلى رأيه ولجاز ذلك في الإخبار فيقول أخبر فإنك لا تخبر إلا عن حق
ولجاز أن يصيب في مسائل الأصول من غير تعلم ألبتة ولجاز أن يفوض إليه تبليغ أحكام الله تعالى من غير وحي نزل عليه وكل ذلك باطل بالإجماع
ورابعها لو جاز ذلك في حق العالم لجاز في حق العامي وبالإجماع لا يجوز
أما الذي يدل على عدم الوقوع فأمران
الأول لو كلن الرسول صلى الله عليه و سلم مأمورا بأن يحكم على وفق أرادته من غير دليل لما كان منهيا عن اتباع هواه لأنه لا معنى لاتباع الهوى إلا الحكم بكل ما يميل قلبه إليه لكنه كان منهيا عن اتباع الهوى لقوله تعالى ولا تتبع الهوى وما ينطق عن الهوى فإن قلت لما قيل له احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب كان ذلك نصا من الله تعالى على كل ما يميل قلبه إليه فلا يكون ذلك اتباعا للهوى
قلت فعلى هذا التقدير صار اتباع الهوى في حقه غير ممكن ولو كان كذلك فلم نهي عنه
الثاني لو قيل له احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب لما قيل له لم فعلت كذا لكن قد قيل له عفا الله عنك لم أذنت لهم فلم يثبت ذلك في حقه
وأما مويس فإنه تعلق بأمور بعضها يدل على الواقع وبعضها يدل على الجواز فقط
أما الدال على الوقوع فإما أن يدل على وقوع ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم أو على وقوعه من غيره
أما الأول فقد ذكر مويس فيه عشرة أوجه
أحدها أن منادي النبي عليه الصلاة و السلام نادى يوم فتح مكة أن اقتلوا مقيس بن حبابة وابن أبي سرح وإن وجدتموهما متعلقين بأستار الكعبة
لقوله من تعلق بأستار الكعبة فهو آمن
ثم عفى عن ابن أبي سرح بشفاعة عثمان رضي الله عنه ولو كان الله تعالى أمر بقتله لما قبل شفاعة
أحد فيه إلا بوحي آخر ولم يوجد وحي آخر لما أن نزول الوحي له علامات كانوا يعرفونها وما ظهر في ذلك الوقت شيء من ذلك
وثانيها أنه قال يوم الفتح إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فقال إلا الإذخر فهذا الحكم ما كان بالوحي لأنه لم تظهر علامة نزول الوحي
وثالثها أنه عليه الصلاة و السلام نادى مناديه لا هجرة بعد الفتح حتى استفاض ذلك فبينما المسلمون كذلك إذ أقبل مجاشع ابن مسعود بالعباس بن عبد المطلب شفيعا ليجعله مهاجرا بعد
الفتح فقال عليه الصلاة و السلام أشفع عمي ولا هجرة بعد الفتح
ورابعها أنه لما قتل النضر بن الحارث جاءته قتيلة بنت النضر فأنشدته
أمحمد ولأنت ضنؤ نجيبة ... في قومها والفحل فحل معرق ... ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق ...
فقال عليه الصلاة و السلام أما أني لو كنت سمعت شعرها ما قتلته ولو كان قتله بأمر الله لقتله ولو سمع شعرها ألف مرة
وخامسها قوله عفوت لكم عن الخيل والرقيق
وسادسها قوله عليه الصلاة و السلام أيها الناس كتب عليكم الحج فقال الأقرع بن حابس أكل عام يا رسول الله يقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه و سلم ساكت فلما أعاد ذلك قال والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها دعوني ما ودعتكم
وسابعها أن أبن عباس رضي الله قال أخر رسول الله صلى الله عليه و سلم العشاء ذات ليلة فخرج ورأسه يقطر
فقال لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين
وثامنها روى جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال إن عشت إن شاء الله لأنهين أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة وهذا الكلام يدل على أنه له
وتاسعها قال جابر لما قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم إن ماعزا رجم فقال هلا تركتموه حتى أنظر في أمره فلو لم يكن حكم الرجم إليه لما قال ذلك
وعاشرها قوله عليه الصلاة و السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وعن لحوم الأضاحي ألا فانتفعوا بها
وأما الذي يدل على وقوع ذلك من غير رسول الله صلى الله عليه و سلم فقوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه
وأما الذي يدل على الجواز فقط فأمور
أحدها أن الواجب من خصال الكفارة ليس إلا الواحد بالدلائل التي تقدم ذكرها في مسألة الواجب المخير ثم أنه تعالى فوضها إلى المكلف لما علم أنه لا يختار إلا ذلك الواجب فدل على أن ذلك جائزوثانيها أن الواجب في التكليف أن يكون المكلف متمكنا من الخروج عن العهدة فإذا قال الله تعالى له احكم فإنك لا تنفك عن الصواب علم أن كل ما يصدر عنه صواب فكان متمكنا من الخروج من العهدة فوجب القطع بجوازه
وثالثها إذا استوى عند المستفتى مفتيان وأحدهما يفتى بالحظر والآخر بالإباحة فهو متمكن شرعا من الأخذ ب قول أيهما أراد ولا فرق في العقل بين أن يقال افعل ما شئت فإنك لا تفعل إلا الصواب وبين أن يقال خذ بقول أيهما
شئت فإنك لا تفعل إلا الصواب
والجواب عن أدلة المانعين أن نقول أما الوجه الذي تمسكوا به أولا في امتناع ذلك عقلا فهو مبني على أن أحكام الله تعالى متفرعة على رعاية المصالح ونحن لا نقول بهذا الأصل فتلك الوجوه بأسرها ساقطة عنا
ثم إنا نسلم لهم هذا الأصل ونبين ضعف كل واحد من تلك الوجوه
أما قوله أولا من أجاز هذا التكليف إما أن يجعل الاختيار مما تتم به المصلحة أو يجعل الفعل مصلحة في نفسه ثم يختاره المكلف
قلنا اخترنا القسم الأول
قوله هذا يكون إسقاطا للتكليف
قلنا لا نسلم وذلك لأنه قال للرسول إن اخترت الفعل فاحكم على الأمة بالفعل وإن اخترت الترك فاحكم على الأمة
بالترك فهذا لا يكون إسقاطا للتكليف بل يكون مكلفا بأن يأمر الخلق بمتعلق اختياره
قوله الفعل والترك لا ينفك المكلف عنهما
قلنا لكن الحكم على الخلق بالفعل والحكم عليهم بالترك قد ينفك عنهما فلم لا يجوز ورود التكليف به
ثم يشكل ما ذكروه بالمستفتي إذ أفتاه مفتيان أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة فكل ما يقولونه هناك فهو قولنا ها هنا سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز القسم الثاني
قوله إما أن يكون مأمورا بذلك في الأفعال الكثيرة أو القليلة
قلنا لم لا يجوز في الكثيرة
قوله الاتفاقي لا يكون أكثريا
قلنا لا نسلم فإن حكم الشيء حكم مثله عقلا وشرعا وعرفا فلما جاز ذلك في الأفعال القليلة جاز في الأفعال الكثيرة أيضا
فان لم يفد هذا الكلام القطع بالجواز فلا أقل من أن لا يحصل معه القطع البديهي بالامتناع
وأما الأمثلة التي ذكروها فنقول
إن كان الحال فيها كما هنا احتاج الفرق بين القليل والكثير إلى دليل وإلا فيمتنع القياس على أنا قد بينا في هذا الكتاب أن القياس لا يفيد اليقين ألبتة
سلمنا أن الاتفاقي لا يدوم ولكن إذا كان الاتفاقي ببعض الجهات معلوم السبب بسائر الجهات أو إذا لم يكن
الأول ممنوع والثاني مسلم
بيانه
أن من الجائز أن يعلم الله تعالى أن أكل الطعام الحلو في هذه السنة مصلحة للمكلفين ويعلم أنهم خلقوا على وجه لا يشتهون إلا الطعام الحلو فإذا كان تناول الطعام الحلو مصلحة طول عمره لم يكن جهله بكون الفعل مصلحة مانعا له في هذه الصورة من الإقدام عليه في أكثر أوقاتهسلمنا تعذر ذلك في الكثير فلم لا يجوز في القليل والإجماع الذي ذكروه ممنوع
أما قوله ثانيا التمييز بين الحسن والقبيح لابد وأن يتقدم على الفعل قلنا لا نسلم
وبيانه بالوجهين المذكورين في الجواب عن الوجه الأول سلمنا ذلك ولكنه حاصل ها هنا لأن الغرض أن يأمن المكلف من أن يفعل قبيحا أو مفسدة يستحق به الذم فأي فرق بين أن يجعل الله تعالى له على ذلك أمارة قبل أن يفعل وبين أن يجعل الأمارة على ذلك نفس الفعل
وعلى الوجهين جميعا هو آمن من القبيح ومتخلص من الذم
وليس يلزم ما قالوا من أن الأمارة إذا لم تتقدم على الفعل كان مقدما على ما لا يأمن كونه قبيحا لأنه قبل أن يفعل لما قيل له إنك لا تختار إلا الصواب فهو آمن من الإقدام على القبيح
وأما الوجه الثالث والرابع فجوابه أن الله تعالى لما نص في تلك الصورة بأن المكلف لا يختار فيها إلا الصواب فلم
قلت لا يجوز ورود الأمر بمتابعة إرادته
وليس إذا لم يلزم مويس لم يجز لغيره التزامه
وأما الوجهان اللذان تمسكوا بهما في نفي الوقوع
فالجواب عنهما أن قوله تعالى لمحمد عليه الصلاة و السلام إنك لا تحكم إلا بالصواب لعله ورد في زمان متأخر وما ذكروه ورد في زمان متقدم فلا يتناقضانوأما الوجوه العشرة التي تمسك بها مويس في الوقوع فضعيفة لاحتمال أن يقال ورد الوحي بها قبل تلك الوقائع مشروطا مثل أن يقال لو استثنى أحد شيئا فاستثن له ذلك وكذا القول في سائر الصور سلمنا أنه ما كان بالوحي فلعله كان بالاجتهاد وبهذا التقدير لا يصح قول الخصم
وأما قوله تعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قلنا يحتمل أن يكون حرم ذلك على نفسه بالنذر أو
بالاجتهاد ويكون إثبات التحريم بالنذر جائزا في شرعهم
وأما الوجه الأول من الوجوه التي تمسكوا بها في الجواز فجوابه
أنه مبني على أن الواجب في خصال الكفارة واحد معين عند الله تعالى لكنا لا نقول بهوأما الوجهان الباقيان فمبنيان على تشبيه صورة بصورة وقد عرفت أن هذا لا يفيد اليقين
فثبت بما ذكرنا ضعف أدلة القاطعين فظهر أن الحق ما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه من التوقف
المسألة السادسة
مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل فإنه حكى اختلاف الناس في دية اليهودي فمنهم من قال بمساواتها لدية المسلم ومنهم من قال هى نصف دية المسلم ومنهم من قال هى الثلث منها فهو رضي الله عنه أخذ بالأقلواعلم أن هذه القاعدة مفرغة على أصلين الإجماع والبراءة الأصلية
أما الإجماع فلأنا لو قدرنا أن الأمة انقسمت إلى أربعة أقسام
أحدها يوجب في اليهودي مثل دية المسلموثانيها يوجب النصف
وثالثها يوجب الثلث
ورابعها لا يوجب شيئا لم يكن الأخذ بأقل ما قيل واجبا لأن ذلك الأقل قول بعض الأمة وذلك ليس بحجة
أما إذا لم يوجد هذا القسم الرابع كان القول بوجوب الثلث قولا لكل الأمة لأن من أوجب كل دية المسلم فقد أوجب الثلث ومن أوجب نصفها فقد أوجب الثلث أيضا ومن أوجب الثلث فقد قال بذلك فيكون إيجاب الثلث قولا قال به كل الأمة فيكون حجة
وأما البراءة الأصلية فلأنها تدل على عدم الوجوب في الكل ترك العمل به في
الثلث لدلالة الإجماع على وجوبه فيبقى الباقي كما كانولهذه النكتة شرطنا في الحكم بأقل ما قيل عدم ورود شيء من الدلائل السمعية فإنه إن ورد شيء من ذلك كان الحكم لأجله لا لأجل الرجوع لأقل ما قيل
ولهذا السر اختلف الناس في العدد الذي تنعقد به الجمعة فقال قائلون أربعون وقال قائلون ثلاثة
فالشافعي رضي الله عنه لم يأخذ بأقل ما قيل لأنه وجد في الأكثر دليلا سمعيا فكان الأخذ به أولى من الأخذ بالبراءة الأصلية
وكذلك اختلفوا في عدد الغسل من ولوغ الكلب فقال بعضهم سبعة وقال آخرون ثلاثة
فالشافعي رضى الله عنه لم يأخذ بالأقل لأنه وجد في الأكثر دليلا سمعيا
فإن قلت لم لا يجوز أن يقال كان يجب الأخذ بأكثر ما قيل لأنه قد ثبت في الذمة شيء واختلفت الأمة في الكمية فقال قوم هو كل الدية وقال آخرون بل نصفها وقال آخرون بل ثلثها فإذا لم تحصل مع واحد من هذه الأقوال دلالة سمعية تساقطت
ولا تحصل براءة الذمة باليقين إلا عند أداء كل دية المسلم فوجب القول به ليحصل الخروج عن العهدة بيقين
والجواب
أنه لما كان الأصل براءة الذمة امتنع الحكم بكونها مشغولة إلا بدليل سمعي فإذا لم يوجد دليل سمعى سوى الإجماع والإجماع لم يثبت إلا في أقل المقادير لم يثبت شغل الذمة إلا بذلك الأقلفإن قلت هب أنه لم يوجد دليل سوى الإجماع لكنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول فلعله ثبت في الذمة حق أزيد من أقل ما قيل
فإذا كان هذا الاحتمال قائما لم يثبت الخروج عن العهدة باليقين
إلا بأكثر ما قيل
قلت لما لا يوجد سوى الإجماع والإجماع لم يدل إلا على أقل ما قيل فيه كان الزائد على ذلك الأقل لو ثبت لثبت من غير دليل وذلك غير جائز لأنه يصير ذلك تكليف مالا يطاق
وأيضا فإن الله تعالى تعبدنا بالبراءة الأصلية إذا لم نجد دليلا سمعيا يصرفنا عنها فإذا لم يوجد دليل سمعي يدل على الزيادة علمنا أن الله تعالى تعبدنا بالبراءة الأصلية
وحينئذ يحصل القطع بأنه لا يجب إلا ذلك القدر الذي هو أقل المقادير
المسألة السابعة
قال قوم يجب على المكلف الأخذ بأخف القولين للنص والمعقولأما النص فقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج
وقوله عليه الصلاة و السلام لا ضرر في الإسلام وقوله بعثت بالحنيفية السهلة السمحة وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل
وأما القياس فهو أنه تعالى كريم غني والعبد محتاج فقير وإذا وقع التعارض بين هذين الجانبين كان التحامل على جانب الكريم الغني أولى منه على جانب المحتاج الفقير وربما قالوا الأخذ بالأخف أخذ بالأقل فوجب العمل به
واعلم أن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل
في الملاذ الإباحة وفي الآلام الحرمة وقد تقدم الكلام فيه
فأما قوله الأخذ بالأخف أخذ بالأقل
قلنا هذا ضعيف لأنا إنما نوجب الأخذ بأقل ما قيل إذا كان ذلك جزءا من الأصل كما ذكرناه في المثال فإن الثلث جزء من النصف ومن الكل والموجب للكل والنصف موجب للثلث فيصير وجوب الثلث بهذا الطريق مجمعا عليه
أما إذا كان الأخف ليس جزءا من ماهية الأصل لم يصر الثلث مجمعا عليه فلا يجب الأخذ به
وقال قوم يجب الأخذ بأثقل القولين لقوله عليه الصلاة و السلام الحق ثقيل قوي والباطل خفيف وبي
وهذه الدلالة ضعيفة لأنه لا يلزم من قولنا كل حق ثقيل أن يكون كل ثقيل حق ولا من قولنا الباطل خفيف أن يكون كل خفيف باطلا
وها هنا طريقة أخرى يسمونها طريقة الاحتياط وهى إما الأخذ بأكثر ما قيل أو بأثقل ما قيل ولما تقدم الكلام فيها فلا فائدة في الإعادة
المسألة الثامنة
الاستقراء المظنون هو إثبات الحكم في كلي لثبوته في بعض جزئياته مثاله قول أصحابنا في الوتر إنه ليس بواجب لأنه يؤدي على الراحلة ولا شيء من الواجب يؤدى على الراحلة أما المقدمة الأولى فثابتة بالإجماع وأما الثانية فنثبتها بالاستقراء وهو أنا لما رأينا القضاء وسائر أصناف الواجبات لا تؤدى على الراحلة حكمنا على كل واجب بأنه لا يؤدى على الراحلة
وهذا النوع لا يفيد اليقين لأنه يحتمل أن يكون الوتر واجبا بخلاف سائر الواجبات في هذا الحكم ولا يمتنع عقلا أن يكون بعض أنواع الجنس مخالفا لحكم النوع الآخر من ذلك الجنس
وهل يفيد الظن أم لا
الأظهر أن هذا القدر لا يفيد إلا بدليل منفصل ثم بتقدير حصول الظن وجب الحكم بكونه حجة لقوله عليه الصلاة و السلام أقضي بالظاهر
المسألة التاسعة في المصالح المرسلة
أعلم أن المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام
أحدها ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس الذي تقدم شرحهوثانيها ما شهد الشرع ببطلانه مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان عليك صوم شهرين متتابعين فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة قال لو أمرته بذلك لسهل عليه ولاستحقر إعتاق رقبة في قضاء شهوته
واعلم أن هذا باطل لأنه حكم على خلاف حكم الله تعالى لمصلحة تخيلها الإنسان بحسب رأيه ثم إذا عرف ذلك من جميع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي
القسم الثالث ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإبطال نص معين فنقول
قد ذكرنا في كتاب القياس أن المناسبة إما أن تكون في محل الضرورة أو الحاجة أو التتمة فقال الغزالي رحمه الله أما الواقع في محل الحاجة أو التتمة فلا يجوز الحكم فيها بمجرد المصلحة لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي
وأما الواقع في رتبة الضرورة فلا يبعد أن يؤدى إليه اجتهاد مجتهد
ومثاله أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا واستولوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما لم يذنب وهذا لا عهد به في الشرع
ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى
فيجوز أن يقول قائل هذا الأسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع من حفظ المسلم الواحد
قال وإنما اعتبرنا هذه المصلحة لاشتمالها على ثلاثة أوصاف وهى أنها ضرورية قطعية كلية
واحترزنا بقولنا ضرورية عن المناسبات التي تكون في مرتبة الحاجة أو التتمة
وبقولنا قطعية عما إذا لم نقطع بتسلط الكفار علينا إذا لم نقصد الترس فإن ها هنا لا يجوز القصد إلى الترس
وكذلك قطع المضطر قطعة من فخذه لا يجوز لأنا لا نقطع بأنه يصير ذلك سببا للنجاة
وبقولنا كلية عما لو تترس الكافر في قلعة بمسلم
فإنه لا يحل رمي الترس إذ لا يلزم من عدم استيلائنا على تلك القلعة فساد يعم كل المسلمين
وكذا إذا كان جماعة في سفينة ولو طرحوا واحدا لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم فها هنا لا يجوز لأن ذلك ليس أمرا كليا فهذا محصل ما قاله الغزالي رحمه الله
ومذهب مالك رحمه الله أن التمسك بالمصلحة المرسلة جائز واحتج عليه بأن قال كل حكم يفرض فإما أن يستلزم مصلحة خالية عن المفسدة أو مفسدة خالية عن المصلحة أو يكون خاليا عن المصلحة والمفسدة بالكلية أو يكون مشتملا عليهما معا
وهذا على ثلاثة أقسام لأنهما إما أن يكونا متعادلين وإما أن تكون المصلحة راجحة وإما أن تكون المفسدة راجحة
فهذه أقسام ستة
أحدها أن يستلزم مصلحة خالية عن المفسدة وهذا لابد وأن يكون مشروعا لأن المقصود من الشرائع رعاية المصالح وثانيهما أن يستلزم مصلحة راجحة وهذا أيضا لابد وأن يكون مشروعا لأن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير
وثالثها أن يستوى الأمران فهذا يكون عبثا فوجب أن لا يشرع
ورابعها أن يخلو عن الأمرين وهذا أيضا يكون عبثا فوجب أن لا يكون مشروعا
وخامسها أن يكون مفسدة خالصة ولا شك أنها لا تكون مشروعة
وسادسها أن يكون ما فيه من المفسدة راجحا على ما فيه من المصلحة وهو أيضا غير مشروع لأن المفسدة الراجحة واجبة الدفع بالضرورة
وهذه الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الستة كالمعلوم بالضرورة أنها دين الأنبياء وهى المقصود من وضع الشرائع والكتاب والسنة دالان على أن الأمر كذلك تارة بحسب التصريح وأخرى بحسب الأحكام المشروعة على وفق هذا الذي ذكرناه
غاية ما في الباب أنا نجد واقعة داخلة تحت قسم من هذه الأقسام ولا يوجد لها في الشرع ما يشهد لها بحسب جنسها القريب لكن لا بد وأن يشهد الشرع بحسب جنسها البعيد على كونه خالص المصلحة أو المفسدة أو غالب المصلحة أو المفسدة فظهر أنه لا توجد مناسبة إلا ويوجد في الشرع ما يشهد لها بالاعتبار إما بحسب جنسه القريب أو بحسب جنسه البعيد
إذا ثبت هذا وجب القطع بكونه حجة للمعقول والمنقول
أما المعقول
فلأنا إذا قطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطعا عند الشرع ثم غلب على ظننا أن هذا الحكم مصلحته غالبة على مفسدته تولد من هاتين المقدمتين ظن أن هذه المصلحة معتبرة شرعا والعمل بالظن واجب لقوله عليه الصلاة السلام أقضي بالظاهر ولما ذكرنا أن ترجح الراجح على المرجوح من مقتضيات العقول وهذا يقتضي القطع بكونه حجةوأما المنقول فالنص والإجماع
أما النص فقوله تعالى فاعتبروا أمر بالمجاوزة والاستدلال بكونه مصلحة على كونه مشروعا مجاوزة فوجبدخوله تحت النص
وأما الإجماع
فهو أن من تتبع أحوال مباحثات الصحابة علم قطعا أن هذه الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان في تحرير الأقيسة والشرائط المعتبرة في العلة والأصل و الفرع ما كانوا يلتفتون إليها بل كانوا يراعون المصالح لعلمهم بأن المقصد من الشرائع رعاية المصالح فدل مجموع ما ذكرنا على جواز التمسك بالمصالح المرسلةالمسألة العاشرة
الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم طريقة عول عليها بعض الفقهاء وتحريره أن الحكم الشرعي لا بد له من دليل والدليل إما نص أو إجماع أو قياس ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة فوجب أن لا يثبت الحكم
إنما قلنا إن الحكم الشرعي لابد له من دليل لأن الله تعالى لو أمرنا بشيء ولا يضع عليه دليلا لكان ذلك تكليف ما لا يطاق وإنه غير جائز
وإنما قلنا إن الدليل إما نص أو إجماع أو قياس لثلاثة أوجه
أحدها قصة معاذ فإنها تدل على انحصار الأدلة في الكتاب والسنة والقياس زدنا فيه الإجماع بدليل منفصل فيبقى الباقي على الأصلوثانيها أن الأدلة الدالة على الأحكام كانت معدومة في الأزل وقد بينا أن الأصل في كل أصل تحقق بقاؤه على ما كان فهذا الدليل يقتضى أن لا يوجد شيء من أدلة الأحكام ترك العمل به في النص والإجماع والقياس فوجب أن يبقى فيما عدا هذه الثلاثة على الأصل
وثالثها أنه لو حصل نوع آخر من الأدلة لكان ذلك من الأمور العظام لأن ما يجب الرجوع إليه في الشرع نفيا وإثباتا في الوقائع الحاضرة والمستقبلة لا شك أنه من الأمور العظام فلو كان ذلك موجودا لوجب اشتهاره ولو كان كذلك لعرفناه بعد البحث والطلب فلما لم نجد شيئا آخر سوى هذه الثلاثة علمنا الانحصار وإنما قلنا إنه لم يوجد واحد من هذه الثلاثة لما سنبينه
أما النص فلوجهين
أحدهما أنا اجتهدنا في الطلب فما وجدنا وهذا القدر عذر في حق المجتهد بالإجماع فوجب أن يكون عذرا في حق المناظر لأنه لا معنى للمناظرة إلا بيان ما لأجله قال بالحكموثانيهما أنه لو وجد في المسألة نص لعرفه المجتهدون ظاهرا ولو عرفوه لما حكموا على خلافه ظاهرا فحيث حكموا على خلافه علمنا عدمه
أما الإجماع فهو منفي لأن المسألة خلافية ولا إجماع مع الخلاف
وأما القياس فمنفي لوجهينأحدهما أن القياس لا بد فيه من أصل والأصل هو الصورة الفلانية والفارق الفلاني موجود ومع الفارق لا يمكن القياس
أقصى ما في الباب أن يقال لم لا يجوز القياس على صورة أخرى
فنقول لأنا بعد الطلب لم نجد شيئا يمكن القياس عليه إلا هذه الصورة
وهذا القدر عذر في حق المجتهد فوجب أن يكون عذرا في حق المناظر على ما بيناه
وثانيهما أن سائر الأصول كانت معدومة فوجب بقاؤها على العدم تمسكا بالاستصحاب فهذا تمام تقرير هذه الدلالة
واعلم أن كل مقدمة لا يمكن تمشية الدليل إلا بها فلو كانت
تلك المقدمة مستقلة بالإنتاج كان التمسك بها في أول الأمر أولى
ورأينا أن هذه الدلالة لا يمكن تمشيتها إلا بإحدى مقدمتين
إحداهما أن عدم الوجدان بعد الطلب يدل على عدم الوجودوثانيهما أن الأمر الفلاني كان معدوما فيحصل الآن ظن بقائه على العدم
وهاتان المقدمتان لو صحتا لكانتا مستقلتين بإنتاج المطلوب فإنه يقال في أول المسألة الحكم الشرعي لا بد له من دليل ولم يوجد الدليل لأني اجتهدت في الطلب وما وجدته وذلك يدل على عدم الوجود
أو يقال ولم يوجد الدليل لأن هذه الدلائل كانت معدومة في الأزل والأصل في كل معدوم بقاؤه على عدمه
وإذا ثبت هذا فقد حصل ظن عدم الدليل فيتولد منه القطع بأنه لو وجد الحكم لوجد الدليل مع ظن أنه لم يوجد ظن عدم الحكم والعمل بالظن واجب
فتقرير هذه الدلالة على هذا الوجه أقل مقدمات وأشد تلخيصا فكان ايرادها على هذا الوجه أولى
فإن قيل قوله الدليل إما نص أو إجماع أو قياس
قلنا هذا لا يتم على قولك لأنك ذكرت هذه العبارة دليلا في المسألة الشرعية وإنها ليست بنص ولا إجماع ولا قياس وعند هذا يلزم أحد محذورين وهو أنه أما أن لا يكون هذا الكلام دليلا في المسألة حتى يتم الحصر أو يبطل الحصر حتى يتم هذا دليلا في المسألة
فإن قلت الكلام عليه من وجهين
أحدهما أني أقول دليل الحكم الشرعي إما نص أو إجماع أو قياس ومدلول دليلي انتفاء الصحة فإن هذا الانتفاء كان حاصلا قبل الشرع فالإخبار عنه يكون إخبارا عن أمر لا تتوقف معرفته على الشرع فلا يكون شرعياوثانيهما أني لا أنفي الصحة إلا بالإجماع لأن الإجماع منعقد على أنه متى لم يوجد شيء من هذه الأشياء وجب نفي الحكم فيكون
الدليل في الحقيقة هو الإجماع
قلت أما الجواب عن الأول فهو أنه لما ثبت انتفاء الصحة لزم ثبوت البطلان ضرورة تعذر القول بالوقف فيكون كلامك دليلا على البطلان بواسطة دلالته على انتفاء الصحة فيكون دليلا على حكم شرعي فيعود المحذور المذكور
وعن الثاني أن الإجماع لم يدل على عدم الصحة ابتداءا بل دل على أنه مهما عدم النص والإجماع والقياس لزم عدم الحكم فيكون الإجماع دليلا على أن عدم هذه الثلاثة دليل على عدم الحكم وعدم هذه الثلاثة مغاير لهذه الثلاثة فيعود الكلام المتقدم
السؤال الثاني أنك جعلت عدم دليل الثبوت دليل العدم فهل تجعل عدم دليل العدم دليل الثبوت أم لا
فإن لم يقل به فقد ناقض لأن نسبة دليل الثبوت إلى الثبوت كنسبة دليل العدم إلى العدم
فإن لزم من عدم دليل الثبوت عدم الثبوت لزم من عدم دليل العدم عدم العدم
وأن لم يلزم ها هنا لم يلزم هناك أيضا إذ لا فرق بينهما في العقل
وإن اعترف بذلك لزم المحذور من وجهين
أحدهما أن عدم دليل العدم دليل على عدم العدم وعدم العدم وجود فعدم دليل العدم دليل على الوجود فقد حصل سوى النص والإجماع والقياس دليل آخر على الوجود فيبطل حصرهموالثاني وهو أنه إذا كان عدم دليل العدم دليلا على الوجود لم يلزم انتفاء الوجود إلا ببيان عدم عدم دليل العدم وعدم العدم وجود
فإذن لا يلزم انتفاء الوجود إلا بوجود دليل العدم لكنك لو ذكرت دليل العدم لاستغنيت عما ذكرت من الدلالة
السؤال الثالث أنك لو اقتصرت في نفي النص على عدم الوجدان فهذا
الطريق إن صح وجب الاكتفاء به في نفي القياس لأنه حاصل فيه وإن لم يصح لم يجز التعويل عليه في هذا المقام
فإن قلت إنما تعرضت لنفي قياس معين لأن المخالف يعتقده قياسا ودليلا وليس في النصوص ما يعتقده دليلا
قلت المخالف كما يعتقد في قياس كونه حجة له فكذلك قد يعتقد في بعض النصوص كونه حجة له فكان يلزم التعرض للأمرين
السؤال الرابع لم قلت إنه لما وجد الفرق بين الصورتين تعذر القياس وذلك لأن الفرق إنما يكون قادحا لو لم يجز تعليل الحكم الواحد بعلتين
فأما إذا كان جائزا احتمل كون الحكم في الأصل معللا بالوصف الذي تعدى إلى الفرع وبالوصف الذي لم يتعد إليه معا فلا يكون ذلك قادحا في القياس
السؤال الخامس أن هذا النظم لا ينفك عن القلب فإن المستدل إذا قال مثلا في بيع الغائب لا نص ولا إجماع ولا قياس في صحته فوجب أن لا تثبت صحته
فيقال وتحريم أخذ المبيع من البائع بعد جريان هذا البيع على المشتري أو تحريم أخذ الثمن من المشتري على البائع حكم شرعي فلا يثبت إلا بنص أو إجماع أو قياس ولم يوجد ذلك فوجب أن لا يثبت
الجواب هذه الدلالة لا تتم إلا مع التمسك بأن الأصل في كل ثابت بقاؤه على ما كان وأنه إنما يجوز العدول عن هذا الأصل إذا وجد دليل يوجب العدول عنه وذلك الدليل لا يكون إلا نصا أو إجماعا أو قياسا
وعلى هذا يسقط السؤال وذلك لأنا نقول مثلا في مسألة بيع الغائب لا شك أن قبل جريان هذا البيع كان المبيع ملكا للبائع والأصل في كل ثابت بقاؤه على ما كان إلا أنا نترك التمسك بهذا الأصل عند وجود نص أو إجماع أو قياس يدل على خلافه ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة فلم يوجد ما يوجب العدول عن التمسك بذلك الأصل وإذا كان كذلك وجب الحكم ببقائه على ما كان
وحاصل الكلام أنى إنما ادعيت الحصر فيما يدل على تغيير الحكم عن مقتضى الأصل والحكم الذي أنتجته من هذا الدليل ليس من باب تغير الحكم بل هو من باب إبقاء ما كان على ما كان فلم يكن ادعاء الحصر في تلك الصورة قادحا في صحة هذه الدلالة
وإذا عرفت هذا فالعبارة الصحيحة عن هذا الدليل أن يقال حكم الشرع إبقاء ما كان على ما كان إلا إذا وجدت دلالة شرعية مغيرة والدلالة المغيرة إما نص أو إجماع أو قياس ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة فلم توجد الدلالة المغيرة فوجب بقاؤه على ما كان
فإن قلت التمسك باستصحاب الأصل كاف فأي حاجة إلى هذا التطويل
قلت المناظر تلو المجتهد ومعلوم أن المجتهد لا يجوز له التمسك باستصحاب حكم الأصل إلا إذا بحث واجتهد في طلب هذه الأدلة المغيرة
فإذا لم يجد في الواقعة شيئا منها حل له فيما بينه وبين الله تعالى أن يحكم بمقتضى الاستصحاب
فأما قبل البحث عن وجود هذه الدلائل المغيرة فلا يجوز له التمسك بالاستصحاب أصلا
فلما ثبت أن الأمر في المجتهد كذلك وجب أن يكون في حق المناظر كذلك لأنه لا معنى للمناظرة المشروعة إلا بيان وجه الاجتهاد
وأما الجواب عن السؤال الثاني فهو أن الاستدلال بعدم المثبت أولى من الاستدلال بعدم النافي على الوجود
وبيانه من وجوه
أحدها أنا لو استدللنا بعدم المثبت على العدم لزمنا عدم ما لا نهاية له وذلك غير ممتنعأما لو استدللنا بعدم النافي على الوجود لزمنا إثبات ما لا نهاية له وهو محال
وثانيها أنا نستدل بعدم ظهور المعجز على يد الإنسان على أنه ليس بنبي ولا نستدل بعدم ما يدل على أنه ليس برسول على كونه رسولا
وثالثها أنه لا يقال إن فلانا ما نهاني عن التصرف في ماله فأكون مأذونا في التصرف ويقال إنه لم يأذن لي في التصرف في ماله فأكون ممنوعا
ورابعها أن دليل كل شيء على حسب ما يليق به فدليل العدم العدم ودليل الوجود الوجود
سلمنا أنه ليس أحد الطريقين أولى من الآخر لكن ذلك يقتضي أن يتعارضا ويتساقطا
وحينئذ يبقى مقتضى الأصل وهو بقاء ما كان على ما كان
وأما السؤال الثالث فليس سؤالا علميا بل هو شيء يتعلق بالوضع والاصطلاح فلا يليق الخوض في أمثاله في الكتب العلمية
وأما السؤال الرابع فجوابه أنا بينا في هذا الكتاب أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين وأن سؤال الفرق سؤال قادح
وأما السؤال الخامس فساقط لأنا لم نقل إنه يلزم من عدم النص والإجماع والقياس بقاء ما كان على ما كان إلا بعد أن بينا أن الأصل في الثابت بقاؤه على ما كان فمعارضة الخصم إنما تلزم لو ثبت أن الأصل في الشيء أن لا يبقى على ما كان ولما كان ذلك باطلا كانت معارضته باطلة
المسألة الحادية عشرة
في تقرير وجوه من الأدلة التي يمكن التمسك بها في المسائل الفقهيةاعلم أن الحكم الملتزم إثباته إما أن يكون عدميا أو وجوديا
فإن كان عدميا أمكن أن يذكر فيه عبارات
إحداها أن يقال هذا الحكم كان معدوما وذلك يقتضي ظن بقائه على العدم والعمل بالظن واجبإنما قلنا إنه كان معدوما لأن المحكوم عليه كان معدوما في الأزل فوجب أن لا يكون الحكم ثابتا في الأزل لأن ثبوت الحكم من غير ثبوت المحكوم عليه عبث وسفه وهو غير جائز على الله تعالى
فإن قلت فهذا يقتضي أن يكون كلام الله تعالى حادثا
قلت لا نسلم لأن المراد من الحكم كون الشخص مقولا له إن لم تفعل هذا الفعل في هذه الساعة عاقبتك ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المعنى لم يكن متحققا في الأزل
وأما بيان أنه لما كان معدوما حصل ظن تحقق ذلك العدم في كل زمان فلما بيناه في مسألة الاستصحاب
وثانيتها أنه لو ثبت الحكم لثبت بدلالة أو أمارة
والأول باطل لأن الأمة مجمعة على أنه ليس في المسائل الشرعية دلالة قاطعة
والثاني أيضا باطل لأن اتباع الأمارة اتباع الظن وهو غير جائز لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا وقول على الله بما لا نعلم وهو غير جائز لقوله تعالى وأن تقولوا على الله مالا تعلمون
وثالتها لو ثبت الحكم لثبت إما لمصلحة أو لا لمصلحة والثاني عبث والعبث غير جائز على الحكيم
والأول لا يخلو إما أن تكون المصلحة عائدة إلى الله تعالى أو إلى العبد
والأول محال لامتناع النفع والضرر عليه تعالى
والثاني أيضا محال لأن المصلحة لا معنى لها إلا اللذة أو ما يكون وسيله إليها والمفسدة لا معنى لها إلا الألم أو ما يكون وسيلة إليه ولا لذة إلا والله تعالى قادر على تحصيلها إبتداءا فيكون توسط شرع الحكم عبثا وكذا القول في المفسدة
فهذا الدليل ينفي شرع الحكم ترك العمل به فيما توافقنا على وقوعه فبقي في المختلف فيه على وفق الأصل
ورابعتها أن هذه الصورة تفارق الصورة الفلانية التي ثبت الحكم فيها في وصف مناسب فوجب أن تفارقها في هذا الحكم
بيان المفارقة في الوصف المناسب هو أنه وجد في الأصل ذلك الوصف الفلاني وأنه مناسب لذلك ويبين ذلك الحكم بطريقه
وبيان أن هذا القدر يمنع من المشاركة في الحكم وذلك لأن هاتين الصورتين لو اشتركتا في الحكم لكان إما أن يكون الحكم الثابت في
الصورتين معللا بوصف مشترك بين الصورتين أو لا يكون كذلك
فإن كان الأول لزم إلغاء الوصف المناسب المعتبر الذي اختص الأصل به وأنه غير جائز
وإن كان الثاني لزم تعليل الحكمين المتماثلين بعلتين مختلفتين وهذا غير جائز لأن إسناد أحد ذينك الحكمين إلى علته إن كان لذاته أو للوازم ذاته لزم في الحكم الذي يماثله إسناده أيضا إلى تلك الماهية لا إلى ماهية أخرى
وإن لم يكن لذاته ولا للوازم ذاته كان الحكم في نفسه غنيا عن تلك العلة والغنى عن الشيء لا يكون مستندا إليه فوجب في ذلك الحكم أن لا يكون مستندا إلى تلك العلة وقد فرضناه مستندا إليها هذا خلف
وخامسها أن الحكم لو ثبت في هذه الصورة لثبت في الصورة الفلانية لأن بتقدير ثبوته في هذه الصورة كان ذلك لدفع حاجة المكلف وتحصيل مصلحته
وهذا المعنى قائم هناك فيلزم ثبوت الحكم هناك فلما لم يوجد هناك وجب أن لا يوجد هاهنا
وسادسها أن هذا الحكم كان منتفيا من الأزل إلى الأبد فكان منتفيا في أوقات مقدرة غير متناهية فوجب أن يحصل ظن الانتفاء في هذه الأوقات لأن الأوقات الغير متناهية أكثر من الأوقات المتناهية والكثرة مظنة الظن فوجب أن يكون الحكم في هذه الأوقات المتناهية مثل الحكم في تلك الأوقات الغير متناهية وذلك يوجب النفي
وسابعها شرع هذا الحكم يفضي إلى الضرر والضرر منفي بالنص وإنما قلنا إنه يفضي إلى الضرر لأنه إن فعل خلافه استحق العقاب وإن لم يفعل بقي في صورة تارك المراد فثبت كونه ضررا فوجب أن لا يكون مشروعا لقوله صلى الله عليه و سلم لا ضرر ولا ضرار
وثامنها لو ثبت هذا الحكم لثبت بدليل وإلا كان ذلك تكليف مالا يطاق وأنه غير جائز لكنه لا دليل لأن ذلك الدليل إما أن أن يكون هو الله تعالى أو غيره
والأول باطل وإلا لزم من قدم الله تعالى قدم الحكم وإلا لزم النقيض وهو خلاف الدليل لكن قدم الحكم عبث
ولا جائز أن يكون غير الله تعالى لأن ذلك الغير إن كان قديما عاد الكلام وان كان محدثا فقد كان معدوما والأصل بقاؤه على العدم
وأيضا فلأن شرط كونه دليلا أن توجد ذاته وأن يوجد له وصف كونه دليلا
فإذن كونه دليلا مشروط بحدوث هذين الأمرين ويكفي في أن لا يكون دليلا عدم أحدهما والمتوقف على أمرين مرجوح بالنسبة إلى ما يتوقف على أمر واحد
فإذن كونه دليلا مرجوح في الظن فوجب أن لا يكون دليلا
وأما إن كان الحكم وجوديا فالطرق الكلية فيه وجوه
أحدها أن المجتهد الفلاني قال به فوجب أن يكون حقا لقوله صلى الله عليه و سلم ظن المؤمن لا يخطىء ترك العمل بهذا في ظن العوام لأن ظنونهم لا تستند إلى وجه صحيح فيبقى معمولا به في حق ظن المجتهد
فإن قلت فقول المجتهد المثبت معارض بقول المجتهد النافي
قلت قول المثبت أولى لأن قول المثبت ناقل عن حكم العقل وقد ذكرنا في باب التراجيح أن الناقل أولى
وأيضا فالنافي يحتمل أنه إنما نفى لأنه وجد له ظن النفي ويحتمل أنه إنما نفى لأنه لم يوجد له ظن الثبوت وعدم وجود الظن لا يكون ظنا
بخلاف المثبت فإنه لا يمكنه الإثبات إلا عند وجود ظن الثبوت فإنه لو لم يوجد له هذا الظن لكان مكلفا بالبقاء على حكم العقل وإذا كان كذلك ثبت أن قول المثبت أولى من قول النافي
وثانيها أن نقول ثبت الحكم في الصورة الفلانية فيجب ثبوته هاهنا
وبيانه بالآية والخبر والأثر والمعقول
أما الآية فمن وجهين
أحدهما قوله تعالى فاعتبروا دلت الآية على الأمر بالمجاوزة والاستدلال بثبوت الحكم في محل الوفاق على ثبوته في محل الخلاف مجاوزة فكان داخلا تحت الأمر وثانيهما قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان والعدل هو التسوية فالله تعالى أمر بالتسوية وهذا تسوية فيكون داخلا تحت الأمر
وأما الخبر فهو أنه عليه الصلاة و السلام شبه القبلة بالمضمضة في حكم شرعي فوجب علينا أيضا تشبيه الحكم بالحكم لقوله تعالى فاتبعوه وهذا الذي عملناه تشبيه صورة بصورة فكان داخلا تحت الأمر
وأما الأثر فهو أن أبا بكر رضي الله عنه شبه العهد بالعقد
وأن عمر رضي الله عنه أمر أبا موسى بالقياس في
قوله قس الأمور برأيك
وإذا ثبت أنهما فعلا ذلك وجب علينا مثله لقوله عليه الصلاة و السلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر
ووأما المقول فهو أن نعين محل الوفاق فنقول الحكم هناك إنما ثبت لحاجته ومصلحته وذلك المعنى قائم هاهنا فورود الشرع بالحكم هناك يكون ورودا به هاهنا
وثالثها أجمعنا على أن حكما ما في علم الله تعالى ثبت ولا شك أن ذلك الحكم إنما ثبت لمصلحة وهذا الحكم بتقدير الثبوت محصل لنوع مصلحة فلا بد وأن يشتركا في قدر مشترك فيعلل بالقدر المشترك وذلك يقتضي ثبوت الحكم
ورابعها أن هذا الحكم بتقدير الثبوت يتضمن تحصيل مصلحة المكلف ودفع حاجته فوجب أن يكون مشروعا لأن جهة كونه مصلحة
جهة الدعاء إلى الشرعية فلو خرجت عن الدعاء إلى الشرعية لكان ذلك الخروج لمعارض والأصل عدم المعارض
وخامسها أن أحد المجتهدين قال بثبوت الحكم والآخر قال بعدمه فالثبوت أولى لأن المسلمين أجمعوا على أنه إذا ورد خبران أحدهما ناقل عن حكم العقل والآخر مبق له فإن الناقل أولى فكذا هاهنا
فإن قلت فالنفى بتقدير وروده بعد الثبوت يكون ناقلا أيضا
قلت لكن على هذا التقدير يتوالى نسخان وبالتقدير الأول لا يحصل إلا نسخ واحد وتقليل النسخ أولى
واعلم أنا إنما جمعنا هذه الوجوه لأن أكثر مناظرات أهل الزمان في الفقه دائرة على أمثال هذه الكلمات
ولما وصلنا إلى هذا الموضع فلنقطع الكلام حامدين الله تعالى ومصلين على أنبيائه ورسله ونسأل الله حسن العاقبة والخاتمة وأن يجعل ما كتبنا حجة لنا لا علينا إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم