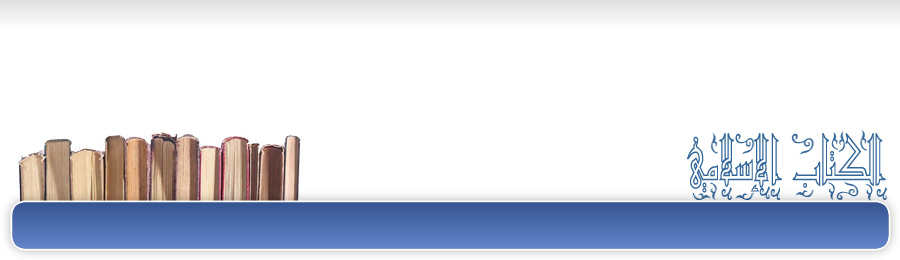كتاب : المحصول في علم الأصول
المؤلف : محمد بن عمر بن الحسين الرازي
الذي أرسله مرة أسنده أخرى أقبل مرسله أو أرسله هو وأسنده غيره وهذ إذا لم تقم الحجة بإسناده أو أرسله راو اخر ويعلم أن رجال أحدهما غير رجال الآخر أو عضده قول صحابي أو توى أكثر أهل العلم أو علم أنه لو نص لم ينص إلا على من يسوغ قبول خبره
قال وأقبل مراسيل سعيد بن المسيب لأني اعتبرتها فوجدتها بهذه الشرائط
قال ومن هذه حاله أحببت قبول مراسليه ولا أستطيع أن أقول إن الحجة تثبت به كثبوتها بالمتصل
قالت الحنفية أما قوله أقبل مراسيل الراوي إذا كان أسنده مرة فبعيد لأنه إذا أسند قبل لأنه مسند وليس لإرساله تأثير
وأما قوله يقبل مرسل الراوي إذا كان قد أسنده غيره فلا يصح لما ذكرنا ولأن ما ليس بحجة لا يصير حجة إذا عضدته الحجة
وأما قوله أقبل المرسل إذا كان أرسله أثنان وشيوخ أحدهما غير شيوخ الآخر لا يصح لأن ما ليس بحجة إذا انضاف إليه ما ليس بحجة لا يصير حجة إذا كان المانع من كونه حجة عند الانفراد قائما عند الاجتماع وهو الجهل بعدالة راوي الأصل وهذا بخلاف الشاهد الواحد فإن المانع من قبول شهادته
الانفراد وهو يزول عند انضمام غيره إليه
والجواب
أن غرض الشافعي رضي الله عنه من هذه الأشياء حرف واحد وهو أنا إذا جهلنا عدالة راوي الأصل لم يحصل ظن كون ذلك الخبر صدقا فإذا انضمت هذه المقويات إليه قوى بعض القوة فحينئذ يجب العمل به إما دفعا للضرر المظنون وإما لقوله عليه الصلاة و السلام أقضي بالظاهر فظهر فساد هذا السؤال
الثاني
إذا أرسل الحديث وأسنده غيره فلا شبهة في قبوله عند من
يقبل المرسل وكذا عند من لا يقبله لأن إسناد الثقة يقتضي القبول إذا لم يوجد مانع ولا يمنع منه إرسال المرسل لأنه يجوز أن يكون أرسله لأنه سمعه مرسلا أو سمعه متصلا لكنه نسى شيخ نفسه وهو يعلم أنه ثقة في الجملة
وكذا القول فيما إذا أرسله مرة وأسنده أخرى لأنه يجوز أن يوجد بعض ما ذكرنا
الثالث
إذا الحق الحديث بالنبي ووافقه غيره على الصحابي فهو متصل لأنه يجوز أن يكون الصحابي رواه عن الرسول صلى الله عليه و سلم مرة وذكر عن نفسه على سبيل الفتوى مرة فرواه كل واحد منهما بحسب ما سمعه أو سمعه أحدهما يرويه عن النبي صلى الله عليه و سلم فنسى ذلك وظن أنه ذكره عن نفسه
الرابع
إذا وصله بالنبي صلى الله عليه و سلم مرة ووقفه على
الصحابي أخرى فإنه يجعل متصلا لجواز أن يكون سمعه من الصحابي يرويه مرة عنه عليه الصلاة و السلام ومرة عن نفسه أو سمعه وصله بالنبي صلى الله عليه و سلم فنسى ذلك وظن أنه ذكره عن نفسه
فأما إذا أرسله أو أوقفه زمانا طويلا ثم أسنده أو وصله بعد ذلك فإنه يبعد أن ينسى ذلك الزمان الطويل إلا أن يكون له كتاب يرجع إليه فيذكر ما قد نسيه الزمان الطويل
الخامس
من يرسل الأخبار إذا أسند خبرا هل يقبل أو يرد
أما من يقبل المراسيل فإنه يقبله
وأما من لا يقبلها فكثير منهم قبله أيضا لأن إرساله مختص بالمرسل دون المسند فوجب قبول مسنده
ومنهم من لم يقبله قال لأن إرساله يدل على أنه إنما
لم يذكر الراوي لضعفه فستره له والحالة هذه خيانة
واختلف من قبل حديث المرسل إذا أسنده كيف يقبل فقال الشافعي رضي الله عنه لا يقبل من حديثه إلا ما قال فيه حدثني أو سمعت فلانا ولا يقبل إذا أتى بلفظ موهم
وقال بعض المحدثين لا يقبل إلا إذا قال سمعت فلانا وهؤلاء يفرقون بين أن يقال حدثني فلان و أخبرني فيجعلون الأول دالا على أنه شافهه بالحديث ويجعلون الثاني مرددا بين المشافهة وبين أن يكون إجازة له أو كتب إليه وهذه عادة لهم وإن لم يكن بينهما فرق في اللغة
المسألة الرابعة
في التدليس
إذا روى الراوي الحديث عن رجل يعرف باسم فلم يذكره بذلك وذكره باسم لا يعرف به فإن فعل ذلك لأن من يروى
عنه ليس بأهل أن يقبل حديثه فقد غش الناس فلا يقبل حديثه
وإن لم يذكر اسمه لصغر سنه لا لأنه ليس بثقة فمن يقول يكفي ظاهر الاسلام في العدالة قبل هذا الحديث
ومن يقول لا بد من التفحص عن عدالته بعد إسلامه فمن لا يقبل المراسيل فإنه لا يقبله لأنه لم يتمكن من التفحص عن عدالته حيث لم يذكر اسمه فهو كالمرسل
ومن يقبل المراسيل ينبغي أن يقبله لأن عدالته تقتضي أنه لولا أنه ثقة عنده لما ترك ذكر اسمه فصار كما لو عدله
المسألة الخامسة
يجوز نقل الخبر بالمعنى وهو مذهب الحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهم خلافا لابن سيرين وبعض
المحدثين
ولكن بشرائط ثلاث
أحدها
أن لا تكون الترجمة قاصرة عن الأصل في إفاده المعنى
وثانيها
أن لا تكون فيها زيادة و لا نقصان
وثالثها
أن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاء والخفاء لأن الخطاب تارة يقع بالمحكم وتارة بالمتشابه لحكم وأسرار استأثر الله بعلمها فلا يجوز تغييرها عن وضعها
لنا وجوه
الأول
أن الصحابة نقلوا قصة واحدة بألفاظ مختلفة مذكورة في مجلس واحد ولم ينكر بعضهم على بعض فيه وذلك يدل على قولنا
الثاني
أنه يجوز شرح الشرع للعجم بلسانهم فإذا جاز إبدال العربية بالعجمية فبأن يجوز إبدالها بعربية أخرى كان أولى
ومن أنصف علم أن التفاوت بين العربية وترجمتها بالعربية أقل مما بينها وبين العجمية
الثالث
روي أنه عليه الصلاة و السلام قال إذا أصبتم المعنى فلا بأس
وعن ابن مسعود أنه كان إذا حدث قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا أو نحوه
الرابع
وهو الأقوى أن نعلم بالضرورة أن الصحابة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الأخبار ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس وما كانوا يكررون عليها في ذلك المجلس بل كما سمعوها تركوها وما ذكروها إلا بعد الأعصار والسنين وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها على تلك الألفاظ
احتج المخالف بالنص والمعقول
أما النص فقوله عليه الصلاة و السلام رحم الله أمرءا اسمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها قالوا وأداؤها كما سمعها هو اداء اللفظ المسموع ونقل الفقه الى من هو أفقه منه معناه
والله أعلم أن الأفطن ربما فطن بفضل فقهه من فوائد اللفظ لما لم يفطن له الرواي لأنه ربما كان دونه في الفقه
وأما المعقول فمن وجهين
الأول
أنه لما جربنا رأينا أن المتأخر ربما استنبط من فوائد آية أو خبر ما لم يتنبه له أهل الأعصار السالفة من العلماء والمحققين فعلمنا أنه لا يجب في كل ما كان من فوائد اللفظ أن يتنبه له السامع في الحال وإن كان فقيها ذكيا فلو جوزنا النقل بالمعنى فربما حصل التفاوت العظيم مع أن الراوي يظن أنه لا تفاوت
الثاني
أنه لو جاز للراوي تبديل لفظ الرسول صلى الله عليه و سلم بلفظ نفسه كان للراوي الثاني تبديل اللفظ الذي سمعه بلفظ نفسه بل هذا أولى لأن جواز تبديل لفظ الراوي أولى من جواز تبديل لفظ الشارع وكذا في الطبقة الثالثة والرابعة وذلك يفضي إلى
سقوط الكلام الأول لأن الأنسان وإن اجتهد في تطبيق الترجمة لكن لا ينفك عن تفاوت وإن قل فإذا توالت هذه التفاوتات كان التفاوت الأخير تفاوتا فاحشا بحيث لا يبقى بين الكلام الأخير وبين الأول نوع مناسبة
والجواب عن الأول
أن من أدى تمام معني كلام الرجل فإنه يوصف بأنه أدى كما سمع وإن اختلفت الألفاظ وهكذا الشاهد والترجمان يقع عليهما الوصف بأنهما أديا كما سمعا وإن كان لفظ الشاهد خلاف لفظ المشهود عليه ولغة المترجم غير لغة المترجم عنه
وعن الثاني والثالث
ما تقدم من قبل
المسألة السادسة
الراويات إذا اتفقا على رواية خبر وانفرد أحدهما بزيادة وهما ممن يقبل حديثه فإما أن يكون المجلس واحدا أو متغايرا
فإن كان متغايرا قبلت الزيادة لأنه لا يمتنع أن يكون الرسول عليه الصلاة و السلام ذكر الكلام في أحد المجلسين مع زيادة وفي المجلس الثاني بدون تلك الزيادة
وإذا كان كذلك فنقول عدالة الراوي تقتضي قبول قوله ولم يوجد ما يقدح فيه فوجب قبوله
وإن كان المجلس واحدا فالذين لم يرووا الزيادة إما أن يكونوا عددا لا يجوز أن يذهلوا عما يضبطه الواحد أو ليسوا كذلك
فإن كان الأول لم تقبل الزيادة وحمل أمر راويها على أنه يجوز مع عدالته أن يكون قد سمعها من غير النبي صلى الله عليه و سلم وظن أنه قد سمعها منه
وإن كان الثاني فتلك الزيادة إما أن لا تكون مغيرة لإعراب الباقي أو تكون
فإن لم تغير إعراب الباقي قبلت الزيادة عندنا إلا إن يكون الممسك عنها أضبط من الراوي لها خلافا لبعض المحدثين
لنا
أن عدالة راوي الزيادة تقتضي قبول خبره وإمساك الراوي الثاني عن روايتها لا يقدح فيه لاحتمال أن يقال إنه كان حال ذكر الرسول عليه الصلاة و السلام تلك الزيادة عرض له سهو أو شغل قلب أو عطاس أو دخول انسان أو فكر أذهله عن سماع تلك الزيادة وإذا وجد المقتضي لقبول الخبر خاليا عن المعارض وجب قبوله فإن قلت كما جاز السهو على الممسك جاز أيضا على الراوي قلت لا نزاع في الجواز على الجملة لكن الأغلب على الظن
أن راوي الزيادة أبعد عن السهو لأن ذهول الإنسان عما سمعه أكثر من توهمه فيما لم يسمع أنه سمعه بلي لو صرح الممسك بنفي الزيادة وقال إنه عليه الصلاة و السلام وقف على قوله فيما سقت السماء العشر فلم يأت بعده بكلام آخر مع انتظارى له فها هنا يتعارض القولان ويصار إلى الترجيح أما إذا كانت الزيادة مغيرة لإعراب الباقي كما إذا روى أحدهما أدوا عن كل حر أو عبد صاعا من بر ويروى الآخر نصف صاع من بر فالحق أنها لا تقبل خلافا لأبي عبد الله البصري
لنا
أنه حصل التعارض لأن أحدهما إذا رواه صاعا فقد رواه بالنصب والآخر اذا روى نصف صاع فقد روى الصاع بالجر والنصب ضد الجر فقد حصل التعارض وإذا كان كذلك وجب المصير إلى الترجيح
فرع
الراوي الواحد إذا روى الزيادة مرة ولم يروها غير تلك المرة فإن أسندهما إلى مجلسين قبلت الزيادة سواء غيرت اعراب الباقي أو لم تغير وإن أسندهما إلى مجلس واحد فالزيادة إن كانت مغيرة للإعراب تعارضت روايتاه كما تعارضتا من راويين وإن لم تغير الإعراب فإما أن تكون روايته للزيادة مرات أقل من مرات الإمساك أو بالعكس أو يتساويان فإن كانت مرات الزيادة أقل من مرات الإمساك لم تقبل الزيادة لأن حمل الأقل على السهو أولى من حمل الأكثر عليه اللهم
إلا أن يقول الراوي إني سهوت في تلك المرات وتذكرت في هذه المرة فها هنا يرجح المرجوح على الراجح لأجل هذا التصريح وإن كانت مرات الزيادة أكثر قبلت لا محالة لوجهين
أحدهما
ما ذكرنا أن حمل الأقل على السهو أولى
والثاني
ما ذكرنا أن حمل السهو على نسيان ما سمعه أولى من حمله على توهم أنه سمع ما لم يسمعه وأما إن تساويا قبلت الزيادة لما بينا أن هذا السهو أولى من ذلك والله أعلم
الكلام في القياس
وهو مرتب على مقدمة وأربعة أقسام أما المقدمة ففيها مسائل
المسألة الأولى في حد القياس أسد ما قيل في هذا الباب تلخيصا وجهان
الأول ما ذكره القاضي أبو بكر واختاره جمهور المحققين منا أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهماوإنما ذكرنا لفظ المعلوم ليتناول الموجود المعدوم فإن القياس زيادة يجرى فيهما جميعا ولو ذكرنا الشيء لاختص بالموجود على مذهبنا ولو ذكرنا الفرع لكان يوهم اختصاصه بالموجود
وأيضا فلا بد من معلوم ثان يكون أصلا فإن القياس عبارة عن التسوية وهي لا تتحقق إلا بين أمرين ولأنه لولا الأصل لكان ذلك إثباتا للشرع بالتحكم
وأيضا فالحكم قد يكون نفيا وقد يكون إثباتا
وأيضا فالجامع قد يكون أمرا حقيقيا وقد يكون حكما شرعيا وكل واحد منهما قد يكون نفيا وقد يكون إثباتا
هذا شرح هذا التعريف
والاعتراض عليه من وجوه
أحدها أن نقولإن أردت بحمل أحد المعلومين على الآخر إثبات مثل حكم
أحدهما للأخر فقولك بعد ذلك في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما إعادة لعين ذلك فيكون ذلك تكريرا من غير فائدة
وإن كان شيئا آخر فلا بد من بيانه
وأيضا فبتقدير أن يكون المراد منه شيئا آخر لكن لا يجوز ذكره في تعريف القياس لأن ماهية القياس تتم بإثبات مثل معلوم لمعلوم آخر بأمر جامع وإذا تمت الماهية بهذا القدر وكان ذلك المعلوم الزائد خارجا فلا يجوز ذكره
وثانيها
أن قوله في إثبات حكم لهما مشعر بأن الحكم في الأصل والفرع مثبت بالقياس وهو باطل فإن القياس فرع
على ثبوت الحكم في الأصل فلو كان ثبوت الحكم في الأصل فرعا على القياس للزم
وثالثها
أنه كما يثبت الحكم بالقياس فقد تثبت الصفة أيضا بالقياس كقولنا الله عالم فيكون له علم قياسا على الشاهد ولا نزاع في أنه قياس لأن القياس أعم من القياس الشرعي والقياس العقلي
وإذا كان كذلك فنقول أما أن تكون الصفة مندرجة في الحكم أو لا تكون
فإن كان الأول كان قوله بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة أو نفيهما عنه تكررا لأن الصفة لما كانت أحد أقسام الحكم كان ذكر الصفة بعد ذكر الحكم تكرارا
وإن كان الثاني كان التعريف ناقصا لأنه ذكر ما إذا كان المطلوب ثبوت المحكم أو عدمه ولم يذكر ما إذا كان المطلوب وجود الصفة أو عدمها فهذا التعريف أما زائد أو ناقص
ورابعها أن المعتبر في ماهية القياس إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر بأمر جامع فأما أن ذلك الجامع تارة يكون حكما وتارة يكون صفة وتارة يكون نفيا للحكم وتارة يكون نفيا للصفة فذاك إشارة إلى ذكر أقسام الجامع والمعتبر في تحقق ماهية القياس الجامع من حيث أنه جامع لاأقسام الجامع بدليل أمرين
الأول أن ماهية القياس قد توجد منفكة عن كل واحد من أقسام الجامع بعينه وإن كان لا بد لها من قسم ما وما ينفك عن الماهية لا يكون معتبرا في تحقق الماهية
والثاني أن الجامع كما ينقسم إلى الحكم والصفة ونفيهما فكذا الحكم
ينقسم إلى الوجوب والحظر وغيرهما والوجوب ينقسم إلى الموسع والمضيق والمخير والمعين وغيرها فلو لزم من اعتبار الجامع في ماهية القياس ذكر أقسامه لوجب من ذكر كل واحد من تلك الأقسام ذكر ما لكل واحد من الأقسام
وخامسها أن كلمة أو للإبهام وماهية كل شيء معينة والإبهام ينافي التعيين
فإن قلت كونه بحيث يلزمه أحد هذه الأمور حكم معين
قلت فالمعتبر إذن في الماهية ملزوم هذه الأمور وهو كونه جامعا من حيث إنه جامع فيكون ذكر هذه الزوائد لغوا
وسادسها هو أن القياس الفاسد قياس وهو خارج عن هذا التعريف
أما الأول فلأن القياس الفاسد قياس مع كيفية فيكون قياسا
وأما الثاني فلأن قوله بأمر جامع دليل على أن هذا القائل يعتبر في حد القياس حصول الجامع ومتى حصل الجامع كان القياس صحيحا فيكون القياس الفاسد خارجا عنه وإنه غير جائز بل يجب أن يقال بأمر جامع في ظن المجتهد فأن القياس الفاسد حصل فيه الجاهل في ظن المجتهد وإن لم يحصل في نفس الأمر
التعريف الثاني ما ذكره أبو الحسين البصري وهو أنه تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد وهو قريب
وأظهر منه أن يقال إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت فلنفسر الألفاظ المستعملة في هذا التعريف
أما الإثبات فالمراد منه القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو بعدمه
وقد يطلق لفظ الإثبات ويراد به الخبر باللسان لدلالته على الحكم الذهنى
وأما المثل فتصوره بديهي لأن كل عاقل يعلم بالضرورة كون الحار مثلا للحار في كونه حارا ومخالفا للبارد في كونه باردا ولو لم يحصل تصور ماهية التماثل والاختلاف إلا بالاكتساب لكان الخالى عن ذلك الاكتساب خاليا عن ذلك التصور فكان خاليا عن هذا التصديق
ولما علمنا أننا قبل كل اكتساب نعلم بالضرورة هذا التصديق المتوقف على ذلك التصور علمنا أن حصول ذلك التصور غنى عن الاكتساب
وأما الحكم فقد مر في أول الكتاب تعريفه
وأما المعلوم فلسنا نعنى به مطلق متعلق العلم فقط بل ومتعلق الاعتقاد والظن لأن الفقهاء يطلقون لفظ المعلوم على هذه الأمور
وأما العلة فسيأتي تفسيرها إنشاء الله تعالى
وقولنا عند المثبت ذكرناه ليدخل فيه القياس الصحيح والفاسد
فإن قيل هذا التعريف ينتقض بقياس العكس وقياس التلازم والمقدمتين والنتيجة
أما قياس العكس فكقولنا لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف لما كان شرطا له بالنذر قياسا على الصلاة فإنها لما لم تكن شرطا لصحة الاعتكاف لم تكن شرطا له بالنذر فالمطلوب في الفرع إثبات كون الصوم شرطا لصحة الاعتكاف والثابت في الأصل نفي كون الصلاة شرطا له فحكم الفرع ليس حكم الأصل بل نقيضه
وأما قياس التلازم فكقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان
وأما المقدمتان فكقولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث فكل جسم محدث
فإن قلت لا أسمي هاتين الصورتين قياسا لأن القياس عبارة عن التسوية وهي لا تحصل إلا عند تشبيه صورة بصورة وليس الأمر كذلك في التلازم وفي المقدمتين والنتيجة
قلت بل التسوية حاصلة في هذين الموضعين لأن الحكم في كل واحدة من المقدمتين معلوم والحكم في النتيجة مجهول فاستلزام المطلوب من هاتين المقدمتين يوجب صيرورة الحكم المطلوب مساوية للحكم في المقدمتين في صفة المعلومية
والجواب أما الشيء الذي سميتموه بقياس العكس فهو في الحقيقة تمسك بنظم التلازم وإثبات لإحدى مقدمتى التلازم بالقياس فإنا نقول لو لم يكن الصوم شرطا في صحة الاعتكاف لما صار
شرطا له بالنذر لكنه يصير شرطا له بالنذر فهو شرط له مطلقا فهذا تمسك بنظم التلازم واستثناء نقيض اللازم لإنتاج نقيض الملزوم ثم إنا نثبت المقدمة الشرطية بالقياس وهو أن ما لا يكون شرطا للشيء في نفسه لم يصر شرطا له بالنذر كما في الصلاة وهذا قياس الطرد لا قياس العكس
وأما الصورتان الباقيتان فلا نسلم أنه قياس لما بينا
قوله معنى التسوية حاصل فيه من الوجه المذكور
قلنا لو كفى ذلك الوجه في إطلاق اسم القياس لوجب أن يسمى كل دليل قياسا لأن المتسك بالنص جعل مطلوبه مساويا لذلك النص في المعلومية ولو صح ذلك لأمتنع أن يقال ثبت الحكم في محل النص بالنص لا بالقياس
فإن أردنا أن نذكر عبارة في تعريف القياس بحيث تتناول كل هذه الصور نقل القياس قول مؤلف من أقوال إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر
وتحقيق القول في هذا التعريف مذكور في كتبنا العقلية
المسألة الثانية في الأصل والفرع
إذا قسنا الذرة على البر في تحريم بيعه بجنه متفضلا فأصل القياس إما أن يكون هو البر أو الحكم الثابت فيه أو علة ذلك الحكم أو النص الدال على ثبوت ذلك الحكمفالفقهاء جعلوا الأصل اسما لمحل الحكم المنصوص عليه
والمتكلون جعلوه اسما للنص الدال على ذلك الحكم
أما قول الفقهاء فضعيف لأن أصل الشيء ما تفرع عنه غيره والحكم المطلوب إثباته في الذرة غير متفرع على البر لأن البر لو لم يوجد فيه ذلك الحكم وهو حرمة الربا لم يمكن تفريع حرمة الربا في الذرة عليه ولو وجد ذلك الحكم في صورة
أخرى ولم يوجد في البر أمكن تفريع حكم الربا في الذرة عليه
فإذن الحكم المطلوب إثباته غير متفرع أصلا على البر بل على الحكم الحاصل في البر فالبر إذن لا يكون أصلا للحكم المطلوب
وأما زيادة قول المتكلمين فضعيف أيضا من هذا الوجه لأنا لو قدرنا كوننا عالمين بحرمة الربا في البر بالضرورة أو بالدليل العقلى لأمكننا أن نفرع عليه حكم الذرة فلو قدرنا أن النص على حرمة الربا في صورة خاصة لم يكن أن نفرع عليه حكم الذرة تفريعا قياسيا وإن أمكن تفريعا نصيا
وإذا كان كذلك لم يكن النص أصلا للقياس بل أصلا لحكم محل الوفاق ولما فسد هذان القولان بقى أن يكون أصل القياس هو الحكم الثابت في محل الوفاق أو علة ذلك الحكم ولابد فيه من تفصيل فنقول
الحكم أصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف والعلة فرع في محل الوفاق أصل في محل الخلاف
وبيانه أنا ما لم نعلم ثبوت الحكم في محل الوفاق لا نطلب علة وقد نعلم ذلك الحكم ولا نطلب علته أصلا فلما توقف إثبات علة الحكم في محل الوفاق على إثبات ذلك الحكم ولم يتوقف إثبات ذلك الحكم على إثبات علة الحكم في محل الوفاق لاجرم كانت العلة فرعا على الحكم في محل الوفاق والحكم أصلا فيه
وأما في محل الخلاف فما لم نعلم حصول العلة فيه لا يمكننا إثبات الحكم فيه قياسا ولا ينعكس فلا جرم كانت العلة أصلا في الخلاف والحكم فرعا فيه
وإذا عرفت ذلك فنقول إن لقول الفقهاء والمتكلمين وجها أيضا لأنه إذا ثبت أن الحكم الحاصل في محل الوفاق
أصل وثبت أن النص أصل لذلك الحكم فكان النص أصلا لأصل الحكم المطلوب وأصل الأصل أصل فيجوز تسمية ذلك النص بالأصل على قول المتكلمين
وأيضا فالحكم الذي هو الأصل محتاج إلى محلة فيكون محل الحكم أصلا للأصل فتجوز تسميته بالأصل أيضا على ما هو قول الفقهاء
وهاهنا دقيقة وهى أن تسمية العلة في محل النزاع أصلا أولى من تسمية محل الوفاق بذلك لأن العلة مؤثرة في الحكم والمحل غير مؤثر في الحكم فجعل علة الحكم أصلا له أولى من جعل محل الحكم أصلا له لأن التعليق الأول أقوى من الثاني
وأما الفرع فهو عند الفقهاء عبارة عن محل الخلاف
وعندنا عبارة عن الحكم المطلوب إثباته لأن محل الخلاف غير متفرع على الأصل بل الحكم المطلوب إثباته فيه هو المتفرع عليه
وهاهنا دقيقة وهى إطلاق لفظ الأصل على محل الوفاق
أولى من إطلاق لفظ الفرع على محل الخلاف لأن محل الوفاق أصل للحكم الحاصل فيه والحكم الحاصل فيه أصل للقياس فكان محل الوفاق أصل أصل القياس
وأما هاهنا فمحل الخلاف أصل للحكم المطلوب إثباته فيه وذلك الحكم فرع للقياس فيكون محل الخلاف أصل فرع القياس وإطلاق اسم الأصل على أصل أصل القياس أولى من إطلاق اسم الفرع على أصل الفرع
واعلم أنا بعد التنبيه على هذه الدقائق نساعد الفقهاء على مصطلحهم وهو أن الأصل محل الوفاق والفرع محل الخلاف لئلا نفتقر إلى تغيير مصطلحهم
المسألة الثالثة
إذا اعتقدنا كون الحكم في محل الوفاق معللا بوصف ثم اعتقدنا حصول ذلك الوصف بتمامه في محل النزاع حصل لا محالة اعتقاد أن الحكم في محل النزاع مثل الحكم في محل الوفاق فإن كانت المقدمتان قطعيتين كانت النتيجة كذلك ولا نزاع بين العقلاء في صحته أما إذا كانتا ظنيتين أو كانت إحداهما فقط ظنية فالنتيجة تكون ظنية لا محالة
وهذا إما أن يكون في الأمور الدنيوية أو في الأحكام الشرعية
فإن كان في الأمور الدنيوية فقد اتفقوا على أنه حجة
وأما في الشرعيات فهو محل الخلاف والمراد من قولنا القياس حجة أنه إذا حصل ظن أن حكم هذه الصورة مثل حكم تلك الصورة فهو مكلف بالعمل به في نفسه ومكلف بأن يفتى به غيره
واعلم أن الجمع بين الأصل والفرع تارة يكون بإلغاء الفارق والغزالي يسميه تنقيح المناط
وتارة باستخراج الجامع وهاهنا لا بد من بيان أن الحكم في الأصل معلل بكذا ثم من بيان وجود ذلك المعنى في الفرع
والغزالي يسمى الأول تخريج المناط والثاني تحقيق المناط
القسم الأول في إثبات أن القياس حجة
اختلف الناس في القياس الشرعي فقلت طائفة العقل يقتضى جواز التعبد به في الجملة وقالت طائفة العقل يقتضى المنع من التعبد به والأولون قسمان منهم من قال وقع التعبد به ومنهم من قال لم يقعأما من اعترف بوقوع التعبد به فقد اتفقوا على أن السمع دل عليه
ثم اختلفوا في ثلاثة مواضع
أحدها أنه هل في العقل ما يدل عليهفقال القفال منا وأبو الحسين والبصرى من المعتزلة العقل يدل على وجوب العمل به
وأما الباقون منا ومن المعتزلة فقد أنكروا ذلك
وثانيها
أن أبا الحسين البصري زعم أن دلالة الدلائل السمعية عليه
ظنية والباقون قالوا قطعية
وثالثها
القاشاني والنهرواني ذهبا إلى العمل بالقياس في صورتين
إحداهما
إذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ أو بإيمائه
والثانية
كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف
أما جمهور العلماء فقد قالوا بسائر الأقيسة
وأما القائلون بأن التعبد لم يقع به فمنهم من قال لم يوجد في السمع ما يدل على وقوع التعبد به فوجب الامتناع من العمل به
ومنهم من لم يقنع بذلك بل تمسك في نفيه بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماع العترة
وأما القسم الثاني وهم الذين قالوا بأن العقل يقتضى المنع من التعبد به فهم فريقان
أحدهما خصص ذلك المنع بشرعنا وقال لأن مبنى شرعنا على الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات وذلك يمنع من القياس وهذا قول النظام
وثانيها الذين قالوا يمتنع ورود التعبد به في كل الشرائع وهؤلاء فرق ثلاث
إحداها الذين قالوا يمتنع أن يكون القياس طريقا إلى العلم والظن
وثانيتها الذين سلموا أنه يفيد الظن لكنهم قالوا لا يجوز متابعة الظن لأنه قد يخطىء وقد يصيب
وثالثها الذين سلموا أنه يجوز متابعة الظن في الجملة ولكن حيث يتعذر النص كما في قيم المتلفات وأروش الجنايات والفتوى والشهادات لأنه لا نهاية لتلك الصور فكان التنصيص على حكم كل واحد منها متعذرا
أما في غير هذه الأحكام فإنه يمكن التنصيص عليها فكان الاكتفاء بالقياس اقتصارا على أدنى البابين مع القدرة على أعلاهما وأنه غير جائز وهذه طريقة داود وأتباعه من أهل الظاهر
فهذا تفصيل المذاهب
والذي نذهب إليه وهو قول الجمهور من علماء الصحابة والتابعين أن القياس حجة في الشرع
لنا الكتاب والسنة والإجماع والمعقول
أما الكتاب فقوله تعالى فاعتبروا يا أولى الأبصار
وجه الاستدلال به أن الاعتبار مشتق من العبور وهو المرور يقال عبرت عليه وعبرت النهر والمعبر الموضع الذي يعبر عليه والمعبر السفينة التي يعبر فيها كأنها أداة العبور والعبرة الدمعة التي عبرت من الجفن وعبر الرؤيا وعبرها جاوزها إلى ما يلازمها
فثبت بهذه الاستعمالات كون الاعتبار حقيقة في المجاوزة فوجب أن لا يكون حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك
والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع فكان داخلا تحت الأمر
فإن قيل لا نسلم أن الاعتبار هو المجاوزة بل هو عبارة عن الاتعاظ لوجوه
أحدها أنه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلى إنه معتبر
وثانيها أن المتفكر في إثبات الحكم من طريق القياس إذا لم يتفكر في أمر معاده يقال إنه غير معتبر أو قليل الاعتبار
وثالثها قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار وإن لكم في الأنعام
لعبرة والمراد به الاتعاظ
ورابعها يقال السعيد من اعتبر بغيره والأصل في الكلام الحقيقة
فهذه الأدلة تدل على أن الاعتبار حقيقة في الاتعاظ لا في المجاوزة فحصل التعارض بين ما قلتم وما قلناه فعليكم الترجيح ثم الترجيح معنا فإن الفهم أسبق إلى ما ذكرنا
سلمنا أن ما ذكرتموه حقيقة و لكن شرط حمل اللفظ على الحقيقة أن لا يكون هناك ما يمنع منه وقد وجد هاهنا ما يمنع فإنه لو قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا الذرة على البر كان ركيكا لا يليق بالشرع
وإذا كان كذلك ثبت أنه وجد ما يمنع من حمل اللفظ على حقيقته
سلمنا أنه لا مانع من حمله على المجاوزة لكن لا نسلم أن الأمر بالمجاوزة أمر بالقياس الشرعي
وبيانه
أن كل من تمسك بدليل على مدلول فقد عبر من الدليل إلى المدلول فمسمى الاعتبار مشترك فيه بين الاستدلال بالدليل العقلى القاطع وبالنص وبالبراءة الأصلية وبالقياس الشرعي فكل واحد من هذه الأنواع يخالف الآخر بخصوصيته وما به
الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فاللفظ الدال على ما به الاشتراك غير دال على ما به الامتياز لا بلفظه ولا بمعناه فلا يكون دالا على النوع الذي ليس إلا عبارة عن مجموع جهة الاشتراك وجهة الامتياز فلفظ الاعتبار غير دال على القياس الشرعي لا بلفظه ولا بمعناه
فإن قلت القدر المشترك بين أنواع مخصوصة لا يوجد إلا عند وجود واحد منها والأمر بالشيء أمر بما هو من ضروراته فالأمر بإدخال الاعتبار في الوجود أمر بإدخال أحد أنواعه في الوجود ثم ليس تعيين أحد أنواعه أولى من تعيين الباقي لأن نسبة القدر المشترك بين أنواع مخصوصة إلى كل واحد منها على السوية فإما أن لا يجب شيء منها وهو باطل لأن تجويز الإخلال بجميع أنواع الماهية يلزم تجويز الإخلال بتلك الماهية فيلزم أن لا يكون مسمى الاعتبار مأمورا به وهو باطل أو يجب جميع أنواع الاعتبار المأمور به في الآية فيكون القياس الشرعي مندرجا فيه
قلت لا نسلم أنه ليس بعض الأنواع أولى من بعض لأن
الاعتبار المأمور به في الآية لا يمكن أن يكون هو القياس الشرعي فقط وإلا لصار معنى الآية
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا الذرة على البر ومعلوم أنه غير جائز بل لا بد من الاعتراف بأن الاعتبار المأمور به يفيد نوعا غير القياس الشرعي وهو الاتعاظ مثلا إلا أنا نقول إنه يفيد الاتعاظ فقط وأنتم تقولون يفيد الاتعاظ والقياس الشرعي
فظهر بهذا أن الأمر بالاعتبار يستلزم الأمر بالاتعاظ ومسمى الاعتبار حاصل في الاتعاظ ففي إيجاب الاتعاظ حصل إيجاب مسمى الاعتبار فلا حاجة إلى إيجاب سائر أنواعه
وأيضا فنحن نوجب اعتبارات أخر
أحدهاإذا نص الشارع على علة الحكم فهاهنا القياس عندنا واجب
وثانيها قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف
وثالثها الأقيسة العقلية
ورابعها الأقيسة في أمور الدنيا فإن العمل بها عندنا واجب
وخامسها أن نشبه الفرع بالأصل في أنه لا يستفاد حكمه إلا من النص
وسادسها الاتعاظ والانزجار بالقصص والأمثال
فثبت بما تقدم أن الآتى بفرد من أفراد ما يسمى اعتبارا يكون خارجا عن عهدة هذا الأمر
وثبت أنا أتينا به في صور كثيرة فلا تبقى فيه دلالة البتة
على الأمر بالقياس الشرعي
سلمنا أن اللفظ يقتضى العموم لكن حمله عليه هاهنا يفضى إلى التناقض لأن التسوية بين الفرع والأصل في الحكم نوع من الاعتبار والتسوية بينهما في أنه لا يستفاد حكم الفرع إلا من النص كما أنه في الأصل كذلك
ولأنه نوع أخر من الاعتبار والأمر بأحد الاعتبارين مناف للأمر بالآخر فإجراء اللفظ على ظاهره يقتضى الأمر بالمتنافيين معا وهو محال
ثم ليس إخراج أحد القسمين من تحت ظاهر العموم لإبقاء الآخر أولى من العكس وعليكم الترجيح
ثم إنه معنا لأن تشبيه الفرع بالأصل في أنه لا يستفاد حكمه إلا من النص عمل بالاحتياط واحتراز عن الظن الذي لا يغنى من الحق شيئا
سلمنا بأن حمله على العموم لا يفضى إلى التناقض لكنه عام دخله التخصيص فوجب أن لا يكون حجة
بيان الأول من وجوه
أحدهماأن الرجل لا يكون مأمورا بالاعتبار عند تعادل الأمارات وفي الأشياء التي ما نصب الله تعالى عليها دليلا كمقادير الثواب والعقاب وأجزاء السماوات والأرض
وفي الأشياء التي عرف حكمها بالاعتبار مرة فالمكلف بعد ذلك لا يكون مأمورا بأعتبار آخر
وثانيها لو قال لوكيله أعتق غانما لسواده فليس للوكيل أن يعتق سالما لسواده
وثالثها أن عند قيام النص في المسألة لا يكون الرجل مأمورا بالعمل بالقياس
ورابعها الأقيسة المتعارضة لا يتناولها الأمر فثبت أن هذا العام مخصوص ومثل هذا العام ليس بحجة على ما سبق بيانه في باب العموم
سلمنا أنه حجة لكن حجة قطعية أو ظنية
الأول ممنوع والثاني مسلم
بيانه أنكم إنما بينتم كون الاعتبار اسما للمجاوزة بتلك الاشتقاقات ولا شك أن التوسل بالاشتقاقات إلى تعيين المسمى دليل ظنى ومسألة القياس مسألة يقينية وبناء اليقيني على الدليل المبنى على المقدمة الظنية لا يجوز
سلنا أنه يفيد اليقين لكنه أمر والأمر لا يفيد التكرار فلا يتناول كل الأوقات
سلمنا أنه يتناول كل الأوقات ولكنه خطاب مشافهة فيختص بالحاضرين في عصر الرسول صلى الله عليه و سلم
والجواب قلنا جعله حقيقة في المجاوزة أولى لوجهين
الأول أنه يقال فلان اعتبر فأتعظ فيجعلون الاتعاظ معلول الاعتبار وذلك يوجب التغاير
الثاني أن معنى المجاوزة حاصل في الاتعاظ فإن الإنسان ما لم يستدل بشيء آخر على حال نفسه لا يكون متعظا
إذا ثبت هذا فنقول لو جعلناه حقيقة في المجاوزة لكان حقيقة في الاتعاظ وغيره على سبيل التواطىء
أما لو جعلناه حقيقة في الاتعاظ كان استعماله في غيره إما بالاشتراك أو بالمجاز وهما على خلاف الأصل
وعلى هذا التقرير لا يضرنا قولهم إن لفظ الاعتبار مستعمل في الاتعاظ فأما قوله لا يقال لمن يستعمل القياس إنه معتبرا
قلنا لا نسلم فإنه يصح أن يقال إن فلانا يعتبر الأشياء القعلية بغيرها بلى من أتى بقياس واحد لا يقال إنه معتبرا على الإطلاق كما أنه لا يقال له إنه قائس على الإطلاق لأن لفظ المعتبر والقائس على الإطلاق لا يستعمل إلا في المكثر منه
قوله المكثر من حمل الفروع على الأصول إذا لم يتفكر في أمر آخرته لا يقال له إنه معتبر
قلنا لما كان الغرض الأعظم من الاعتبار هو العمل للآخرة فإذا لم يأت بما هو المقصود الأصلى قيل إنه غير معتبر على سبيل المجاز كما يقال لمن لا يتدبر في الآيات إنه أعمى وأصم
وأما قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة
قلنا معنى المجاوزة حاصل فيه لأن النظر في خلقها يفيد العلم بوجود صانعها
قوله سلمناه أنه حقيقة في المجاوزة و لكن لكن وجد ما يمنع من حمله عليها قلنا
لا نسلم
قوله لو قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا الذرة على البر كان ركيكا
قلنا لا نزاع في أنه لو نص على هذه الصورة كان ركيكا لأنه لا مناسبة بين خصوص هذا القياس وبين قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي
المؤمنين لكن لم قلت إنه لو أمر بمطلق الاعتبار الذي يكون القياس الشرعي أحد جزئياته كان ركيكا
مثاله لو سأله عن مسألة فأجاب بما لا يتناول تلك المسألة كان باطلا
أما لو أجاب بما يتناول تلك المسألة وغيرها كان حسنا
قوله الأمر بالاعتبار لا يقتضى إلا إدخال فرد من أفراد هذه الماهية في الوجود
قلنا بل يقتضى العموم لدليلين
الأول أن ترتيب الحكم على المسمى يقتضى أن علة ذلك الحكم هو ذلك المسمى وذلك يقتضى أن علة الأمر بالاعتبار هو كونه اعتبارا فيلزم أن يكون كل اعتبار مأمورا به
الثاني أنه يحسن أن يقال اعتبر إلا الاعتبار الفلانى وقد بينا في باب العموم أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحت اللفظ فعلمنا أن كل الاعتبارات داخلة تحت هذا اللفظ
قوله لو حملناه على العموم لا يفضى إلى التناقض
قلنا هب إنه كذلك لكنا نقول لا يجوز أن يكون المراد منه تشبيه الفرع بالأصل في أنه لا يستفاد حكمه إلا من النص وذلك لوجهين
الأول أن الاعتبار المذكور هاهنا لابد وأن يكون معناه لائقا بما قبل هذه الآية وما بعدها وإلا جاءت الركاكة والذي يليق به هو التشبيه في الحكم لا المنع منه وإلا لصار معنى الآية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فلا تحكموا هذا الحكم في حق غيرهم إلا بنص وارد في حق ذلك الغير
ومعلوم أن ذلك باطل وإذا بطل حمل الآية عليه وجب حملها على التشبيه في الحكم عملا بعموم اللفظ
الثاني هو أن المتبادر إلى الفهم من لفظ الاعتبار هو التشبيه في الحكم لا المنع منه ولذلك فإن السيد إذا ضرب بعض عبيده على ذنب صدر منه ثم قال للأخر اعتبر به فهم منه الأمر
بالتسوية في الحكم لا الأمر بالمنع منه
قوله إنه عام مخصوص
قلنا هذا مسلم لكنا بينا في باب العموم أن العام المخصوص حجة
قوله بعض مقدمات هذه الدلالة ظنية
قلنا هذا السؤال عام في كل السمعيات فلا يكون له تعلق بخاصية هذه المسألة
قوله الأمر لا يفيد التكرار
قلنا إنه لما كان أمرا بجميع الأقيسة كان متناولا لا محالة لجميع الأوقات وإلا قدح ذلك في كونه متناولا لكل الأقيسة
قوله هو خطاب مع أولئك الذين كانوا في عصر الرسول صلى الله عليه و سلم فلم قلتم إنه يتناولنا
قلنا للإجماع على عدم الفرق
المسلك الثاني
التمسك بخبر معاذ وهو مشهور روى أنه صلى الله عليه و سلم أنفذ معاذا وأبا موسى الأشعرى رضى الله عنهما إلى اليمن فقال عليه الصلاة و السلام لهما بما تقضيان فقالا إذا لم نجد الحكم في السنة نقيس الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى الحق عملنا به فقال علية الصلاة والسلام أصبتماوقال عليه الصلاة و السلام لأبن مسعود اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما فإن لم تجد الحكم فيهما فأجتهد برأيك فان قيل لا نسلم صحة الحديث
وبيانه من وجهين
الأول أنه مشتمل على الخطأ فوجب أن لا يكون صحيحا
بيان الأول من وجوه
أحدها أن فيه قوله فإن لم تجد في كتاب الله وهو يناقض قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
وثانيها أن في الحديث أنه عليه الصلاة و السلام صوبه على قوله أجتهد رأيي وهو خطأ لأن الاجتهاد في زمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز على ما سيأتي دليله إن شاء الله تعالى
وثالثها أنه عليه الصلاة و السلام سأله عما به يقضى والقضاء هو الإلزام فيكون السؤال واقعا عن الشيء الذي يجب الحكم به والسنة لا تصلح جوابا عن ذلك لأنها تذكر في مقابلة الفرض هذا سنة وليس بفرض
ورابعها أن الحديث يقتضى أنه سأله عما به يقضي بعد أن نصبه للقضاء
وذلك لا يجوز لأن جواز نصه للقضاء مشروطا بصلاحيته للقضاء وهذه الصلاحية إنما تثبت لو ثبت كونه عالما بالشيء الذي يجب أن يقضى به والشيء الذي لا يجب أن يقضى به
وخامسها أن مقتضى الحديث أنه لا يجوز الاجتهاد إلا عند عدم وجدان الكتاب والسنة وهو باطل لأن تخصيص الكتاب والسنة بالقياس جائز
الوجه الثاني في بيان ضعف الحديث
روى أن معاذا لما قال أجتهد رأيي قال له الرسول صلى الله عليه و سلم اكتب إلي أكتب إليك وليس لأحد أن يقول إنا نصحح الروايتين لأنهما نقلا في واقعة واحدة فإنه لا يمكن الجمع بينهما
سلمنا سلامة المتن عن هذه المطاعن لكن لا نزاع بين المحدثين في كونه مرسلا والمرسل ليس بحجة على ما تقدم بيانه
سلمنا أنه ليس بمرسل ولكنه ورد في إثبات القياس والاجتهاد وإنه أصل عظيم في الشرع والدواعي تكون متوفرة على نقل ما هذا شأنه وما يكون كذلك وجب بلوغه في الاشتهار إلى حد التواتر فلما لم يكن كذلك علمنا أنه ليس بحجة
والحاصل أنه مرسل فوجب أن لا يكون حجة عند الشافعي رضى الله عنه
وأنه خبر وارد فيما تعم به البلوى فوجب أن لا يكون حجة عند أبي حنيفة سلامته عن هذا الأمر لكنه خبر واحد فلا يجوز التمسك به في المسائل القطعية
فإن قلت الدليل على صحته أن مثبتى القياس كانوا أبدا متمسكين به في إثبات القياس والنفاة كانوا مشتغلين بتأويله وذلك يدل على اتفاقهم على قبوله قلت قد تقدم بيان ضعف هذا الوجه
سلمنا صحته فلم يدل على كون القياس حجة
أما قوله أجتهد رأيي
قلنا الاجتهاد عبارة عن استفراغ الجهد في الطلب فنحمله على طلب الحكم من النصوص الخفية
فإن قلت إنما قال أجتهد رأيي بعد أن كان لا يجده في الكتاب والسنة وما دلت النصوص الخفية عليه
لا يجوز أن يقال انه غير موجود في الكتاب والسنة
قلنا لا نسلم أن قوله فإن لم تجده يقتضى العموم
بيانه أنه يصح أن يستفهم فيقال أتعني بقولك فإن لم تجد عدم الوجدان في صرائحه فقط أم فيه وفي جميع وجوه دلالته
سلمنا أنه بظاهرة للعموم لكن هاهنا لا يمكن حمله على العموم لأن العمل بالقياس مفهوم عندكم من الكتاب والسنة فكيف يصح حمل قوله فإن لم تجد على العموم
سلمنا أنه يمكن حمله على العموم لكن قوله أجتهد رأيي يكفى في العمل بمقتضاه نوع واحد من الاجتهاد فنحمله على التمسك بالبراءة الأصلية أو على التمسك بما ثبت في العقل من أن الأصل في الأفعال الإباحة أو الحظر
سلمنا أنه لا يجوز حمله عليه فلم قلتم إنه لما لم يجز
حمله على النص الخفي وعلى دليل العقل وجب حمله على القياس الشرعي وما الدليل على الحصر
فإن هاهنا طرقا أخرى سوى القياس كالتمسك بالمصالح المرسلة والتمسك بطريقة الاحتياط في تنزيل اللفظ على أكثر مفهوماته أو أقل مفهوماته أو قول الشارع احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب وبالجملة فلابد من دليل على الحصر
سلمنا أنه يتناول القياس الشرعي ولكن يكفي في العمل بمقتضاه إثبات نوع واحد من أنواع القياس الشرعي ونحن نقول به فإن مذهب النظام أن الشرع إذا نص على علة الحكم وجب القياس ورد الأمر بالقياس أو لم يرد
ويجب أيضا قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف
سلمنا أنه يدل على جواز العمل بالقياس الشرعي لكن في زمان حياة الرسول صلى الله عليه و سلم أو بعده على الإطلاق الأول مسلم والثاني ممنوع
بيانه أن شرط العمل بالقياس عدم الوجدان في الكتاب والسنة وذلك إنما يمكن في زمان حياة الرسول صلى الله عليه و سلم لعدم استقرار الشرع فأما بعد نزول قوله تعالى أليوم أكملت لكم دينكم فإن هذا متعذر لأن الدين إنما يكون كاملا أن لو بين فيه جميع ما يحتاج إليه وذلك إنما يكون بالتنصص على كليات الأحكام
وإذا كان جميع الأحكام موجودا في الكتاب والسنة وكان العمل بالقياس مشروطا بعدم الوجدان فيهما لم يجز العمل بالقياس بعد زمان الرسول صلى الله عليه و سلم
والجواب قوله هذا الحديث مناف لكتاب الله تعالى قلنا لا نسلم وأما قوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء
قلنا هذه الأدلة تدل على اشتمال الكتاب على كل الأمور إبتداء أو بواسطة
الأول باطل
لخلو ظاهر كتاب الله تعالى عن دقائق الهندسة والحساب وتفاريع الحيض والوصايا
والثاني
لا يضرنا لأن كتاب الله تعالى لما دل على وجوب قبول قول الرسول صلى الله عليه و سلم وقول الرسول دل على أن القياس حجة والقياس دل على هذه الأحكام كان كتاب الله تعالى دالا على هذه الأحكام
قوله الحديث يدل على جواز الاجتهاد في زمان الرسول صلى الله عليه و سلم
قلنا وأي محذور يلزم منه فإن الواقعة التي لا يمكن تأخير الحكم فيها إلى مدة يذهب الرجل من اليمن إلى المدينة ويرجع عنها لا يكون تحصيل النص فيها ممكنا فوجب جواز الرجوع إلى القياس
قوله ذكر السنة جوابا عما به يقضى غير جائز
قلنا لا نسلم لأن السنة عبارة عن الطريقة كيف كانت
قوله لا يجوز نصبه للقضاء إلا بعد العلم بأنه يعرف التمييز بين ما يجوز به القضاء وبين ما لا يجوز
قلنا المراد بقوله لما بعث معاذا إلى اليمن لما عزم على أن يبعثه
قوله الحديث يمنع من تخصيص الكتاب والسنة بالقياس
قلنا كثير من الناس ذهب إليه
قوله نقل أنه عليه الصلاة و السلام قال اكتب إلي أكتب إليك
قلنا روايتنا مشهورة وروايتكم غريبة لم يذكرها أحد من المحدثين فلا يحصل التعارض
وأيضا فكيف يجوز أن يقول عليه الصلاة و السلام اكتب إلي أكتب إليك وقد يعرض من الحكم مالا يجوز تأخيره
وأيضا يمكن الجمع بينهما وإن وردا في واقعة واحدة وهو أن يقال الحادثة إن احتملت التأخير وجب عرضها
وإن لم تحتمل وجب الاجتهاد
قوله إنه مرسل
قلنا هب أنه كذلك لكنه مرسل تلقته الأمة بالقبول ومثله حجة عندنا
قوله وارد فيما تعم به البلوى فوجب بلوغه إلى حد التواتر
قلنا وروده فيما تعم به البلوى لا يوجب كونه متواترا بدليل المعجزات المنقولة عن النبي صلى الله عليه و سلم
قوله إنه خبر واحد
قلنا هب أنه كذلك لكن لا نثبت به القطع بكون القياس حجة بل ظن كونه حجة
قوله نحمله على طلب النص الخفى
قلنا قوله فإن لم تجد يقتضى نفي النص جليا كان أو خفيا
قوله لا نسلم أن قوله فإن لم تجد للعموم
قلنا الدليل الدال على انه للعموم جواز الاستثناء
قوله لما دل الكتاب والسنة على العمل بالقياس كان دليلا على الحكم الثابت بالقياس
قلنا هب أنه كذلك ولكن الحكم الذي هو مدلول القياس لا يكون حاصلا فيهما وهذا القدر يكفى في جواز أن يقال إنه غير موجود في الكتاب والسنة وقول معاذ أحكم بكتاب الله أراد به ما دل عليه الكتاب بنفسه لا بواسطة إذ لو أراد به كل ما دل عليه الكتاب سواء كان ابتداء أو بواسطة لكان القول بأنه إذا لم يوجد في الكتاب حكمت بما في السنة خطأ
قوله نحمله على البراءة الأصلية
قلنا البراءة الأصلية معلومة لكل احد فلا حاجة في معرفتها إلى الاجتهاد فلا يجوز حمل قوله أجتهد عليه
قوله نحمله على القياس الذي نص الشرع على علته أو على ما يكون مثل قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف
قلنا الشرع إنما سكت عند قوله أجتهد لعلمه بأن الاجتهاد واف بجميع الأحكام فلو حملناه على ما ذكرتموه من القياس لم يكن ذلك وافيا بمعرفة عشر عشير الأحكام فكان يجب أن لا يسكت عليه كما لم يسكت عند قوله أقضي بالكتاب والسنة
قوله ما الدليل على الحصر
قلنا أجمعت الأمة على الحصر فوجب القطع به
المسلك الثالث
روى أن عمر رضى الله عنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن قبلة الصائمفقال أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه
وجه الاستدلال به أنه عليه الصلاة و السلام استعمل القياس وذلك يوجب كون القياس حجة
إنما قلنا إنه استعمل القياس لأنه عليه الصلاة و السلام حكم بأن القبلة من دون الإنزال لا تفسد الصوم كما أن المضمضة من دون الأزدراد لا تفسد الصوم وإيراد هذا الكلام يدل على أن الجامع بينهما ما يفهمه كل عاقل عند سماع هذا الكلام من
أنه لم يحصل عند المقدمتين ما هو الثمرة المطلوبة فوجب أن لا يكون حكم المقدمة كحكم الثمرة المطلوبة
وإنما قلنا إنه عليه الصلاة و السلام لما استعمل القياس وجب أن يكون حجة لوجهين
الأول أن التأسي به واجب
الثاني أن قوله صلى الله عليه و سلم أرأيت خرج مخرج التقرير فلولا أنه عليه الصلاة و السلام قد مهد عند عمر رضى الله عنه التعبد بالقياس لما قرر ذلك عليه
ألا ترى أن الإنسان لو حكم بحكم من الكتاب جاز أن يقول لمن سأله عنه أليس قد قال الله تعالى كذا وكذا إذا كان الكتاب عنده وعند من يخاطبه حجة ولا يجوز أن يقول ذلك إذا كان هو ومن يخاطبه لا يعتقدان كونه حجة
ولا يقول الإنسان في حكم حكم به لأجل القياس أليس أن القياس يقتضيه مع أنه ومن خاطبه لا يعتقدان كون القياس حجة
فإن قيل هذا خبر واحد فلا يجوز بناء المسألة العلمية عليه
سلمنا ذلك لكن لم قلت إنه عليه الصلاة و السلام نبه هاهنا على العلة ومثل هذا القياس عندنا حجة
سلمنا دلالة الحديث على أن القبلة تجرى مجرى المضمضة لكن ليس فيه أن النص أوجب ذلك أو القياس وإذا احتملا لم يجز القطع على أحدهما بغير دليل
والجواب قوله هذا خبر واحد
قلنا سبق الجواب عنه
قوله نبه على العلة
قلنا إنه عليه الصلاة و السلام ما نص على العلة ولكنه لم يفعل
إلا أنه ذكر أصل القياس بلى العلة متبادرة إلى الإفهام والتنصيص على أصل القياس لا يكون تنصيصا على العلة
قوله إنه ليس في الحديث أنه عليه الصلاة و السلام أجرى القبلة مجرى المضمضة لأجل نص أو لأجل قياس
قلنا بينا أن المفهوم من قوله عليه الصلاة و السلام أرأيت لو تمضمضت هو أن كل واحد منهما لم يحصل الثمرة المطلوبة بذلك الفعل ولو أن بعض العامة فضلا عن أهل العلم استفتى فقيها في صائم قبل ولم ينزل فقال له الفقيه أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته لاكتفى المستفتى بذلك في
أن القبلة لا تفسد صومه ولعلم أنه أجرى أحدهما مجرى الآخر من الوجه الذي ذكرناه فبطل أن يقال إن هذا الكلام لا يدل على الوجه الجامع بينهما وأنه لا يمتنع أن يكون بعض الظواهر اقتضى الجمع
المسلك الرابع
التمسك بقوله عليه الصلاة و السلام للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين قضيته أكان يجزي فقالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاءووجه الاستدلال به كما في قبلة الصائم من غير تفاوت
المسلك الخامس
الإجماع وهو الذي عول عليه جمهور الأصوليين وتحريره أن العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة و كل ما كان مجمعا عليه بين الصحابة فهو حق فالعمل بالقياس حق
أما المقدمة الثانية فقد مر تقريرها في باب الإجماع
وأما المقدمة الأول فالدليل عليها أن بعض الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس والقول به ولم يظهر من أحد منهم الإنكار على ذلك ومتى كان كذلك كان الإجماع حاصلا
فهذه مقدمات ثلاث
المقدمة الأولى
في بيان أن بعض الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس والقول به والدليل عليه وجوه أربعة
الوجه الأول ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعرى في رسالته المشهورة اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك وهذا صريح في المقصود
الوجه الثاني أنهم صرحوا بالتشبيه لأنه روى عن ابن عباس رضى الله عنهما
أنه أنكر على زيد قوله الجد لا يحجب الأخوة فقال ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا
ومعلوم أنه ليس مراده تسمية الجد أبا لأن ابن عباس رضى الله عنهما لا يذهب عليه مع تقدمه في اللغة أن الجد لا يسمى أبا حقيقة ألا ترى أنه ينفي عنه هذا الاسم فيقال إنه ليس أبا للميت ولكنه جده فلم يبق إلا أن مراده أن الجد بمنزلة الأب في حجبه الإخوة كما أن ابن الابن بمنزلة الابن في حجبهم
وعن على وزيد أنهما شبهاهما بغصني شجرة وجدولى نهر فعرفا بذلك قربهما من الميت ثم شركا بينهما في الميراث
الوجه الثالث أنهم اختلفوا في كثير من المسائل وقالوا فيها أقوالا ولا يمكن أن تكون تلك الأقوال إلا عن
القياس واعلم أن الأصوليين أكثروا من تلك المسائل إلا أن أظهرها أربع
إحداها مسألة الحرام فإنهم قالوا فيها خمسة أقوال فنقل عن على وزيد وابن عمر رضى الله عنهم أنه في حكم التطليقات الثلاث
وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه في حكم التطليقة الواحدة إما بائنة أو رجعية على اختلاف بينهم
وعن أبي بكر وعمر وعائشة رضى الله عنهم أنه يمين تلزم فيه الكفارة
وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه في حكم الظهار
وعن مسروق رحمه الله أنه ليس بشيء لأنه تحريم لما أحله الله تعالى فصار كما لوا قال هذا الطعام على حرام
والمرتضى روى هذا القول عن على رضى الله عنه
وثانيتها أنهم اختلفوا في الجد مع الإخوة فبعضهم ورث الجد مع الإخوة وبعضهم أنكر ذلك
والأولون اختلفوا فمنهم من قال إنه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث فأجراه مجرى الأم ولم ينقص حقه عن حقها لأن له مع الولادة تعصيبا
ومنهم من قال إنه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من السدس وأجراه مجرى الجدة في أن لا ينقص من حقها السدس
وثالثتها اختلافهم في مسألة المشتركة وهى زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم حكم عمر رضى الله عنه فيها بالنصف للزوج وبالسدس للأم وبالثلث للإخوة من الأم ولم يعط للإخوة من الأب والأم شيئا فقالوا هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشرك بينهم وبين الإخوة من الأم في الثلث
ورابعتها اختلافهم في الخلع هل يهدم من الطلاق شيئا أو يبقى عدد الطلاق على ما كان
ففي إحدى الروايتين عن عثمان رضى الله عنه أنه طلاق
والرواية الأخرى أنه ليس بطلاق وهو محكى عن ابن عباس وإذا عرفت هذه المسائل فنقول إما أن يكون ذهاب كل واحد منهم إلى ما ذهب إليه لا عن طريق أو عن طريق
والأول باطل لأن الذهاب إلى الحكم لا عن طريق باطل فلو اتفقوا عليه كانوا متفقين على الباطل وأنه غير جائز
وأما إن ذهبوا إليها عن طريق فذلك الطريق إما أن يكون هو العقل أو السمع
والأول باطل لأن حكم العقل في المسألة شيء واحد وهو البراءة الأصلية وهذه أقاويل مختلفة أكثرها يخالف حكم العقل
وأما الثاني فلا يخلو إما أن يكون ذلك الدليل نصا أو غيره
أما النص فسواء كان قولا أو فعلا وسواء كان جليا أو خفيا فالقول به باطل لأنهم لو قالوا بتلك الأقاويل لنص لأظهروه ولو أظهروه لاشتهر ولو اشتهر لنقل ولو نقل لعرفه الفقهاء والمحدثون ولما لم يكن كذلك علمنا أنهم لم يقولوا بتلك الأقاويل لأجل نص
وإنما قلنا إنهم لو قالوا بتلك الأقاويل لأجل نص لأظهروه لأنا نعلم بالضرورة أنه كان من عاداتهم إعظام نصوص الرسول صلى الله عليه و سلم واستعظام مخالفتها حتى نقلوا منها ما لا يتعلق به حكم كقوله عليه الصلاة و السلام نعم الإدام الخل
وكان من عادتهم أيضا التفحص عن نصوص الرسول عليه الصلاة و السلام والحث على نقلها إليهم ليتمسكوا بها إن كانت موافقة لمذاهبهم أو ليرجعوا عن مذاهبهم إن كانت مخالفة لها وليس يجوز فيمن هذه عادته أن يحكم في قضية بحكم لنص ثم يسكت عن ذكر ذلك النص وذلك معلوم بالضرورة
وبهذا الطريق ثبتت المقدمة الثانية وهى قولنا لو أظهر النص لاشتهر ولو اشتهر لنقل ولو نقل لعرفه الفقهاء والمحدثون
وأما أن ذلك لم ينقل فلأنا بعد البحث التام والطلب الشديد والمخالطة للفقهاء والمحدثين ما وجدنا في ذلك ما يدل على نقلها وذلك يدل على عدمها
فثبت أنهم لم يقولوا بتلك الأقاويل لأجل نص وإذا بطل ذلك ثبت أنه لأجل القياس
الوجه الرابع
نقل عن الصحابة القول بالرأى والرأى هو القياس و إنما قلنا إنهم قالوا بالرأى لأنه روى عن أبي بكر أنه قال في الكلالة أقول فيها برأييوفي الجنين لما سمع الحديث لولا هذا لقضينا فيه برأينا
وقول عثمان لعمر رضى الله عنهما في بعض الأحكام إن اتبعت رأيك فرأيك رشيد وإن تتبع رأى من قبلك فنعم ذو الرأى كان
وعن على رضى الله عنه اجتمع رأيي ورأى عمر في أم الولد على أن لا تباع وقد رأيت الآن بيعهن
وعن ابن مسعود رضى الله عنه في قصة بروع أقول فيها برأيي
وإنما قلنا إن الرأى عبارة عن القياس لأنه يقال للإنسان أقلت هذا برأيك أم بالنص فيجعل أحدهما في مقابلة الآخر وذلك يدل على أن الرأى لا يتناول الاستدلال بالنص سواء كان جليا أو خفيا
فثبت بهذه الوجوه الأربعة أن بعض الصحابة ذهب إلى القول بالقياس والعمل به
وأما المقدمة الثانية وهى أنه لم يوجد من أحدهم إنكار أصل القياس فلأن القياس أصل عظيم في الشرع نفيا وإثباتا فلو أنكر بعضهم لكان ذلك الإنكار أولى بالنقل من اختلافهم في مسألة
الحرام والجد ولو نقل لاشتهر ولوصل إلينا فلما لم يصل إلينا علمنا أنه لم يوجد
وتقرير مقدمات هذا الكلام ما تقدم مثله في المقدمة الأولى
وأما المقدمة الثالثة وهى
أنه لما قال بالقياس بعضهم ولم ينكره أحد منهم فقد انعقد الإجماع على صحته فالدليل عليه أن سكوتهم إما أن يقال إنه كان عن الخوف أو عن الرضا
والأول باطل
لأنا نعلم من حال الصحابة شدة انقيادهم للحق لا سيما فيما لا يتعلق به رغبة ولا رهبة في العاجل أصلا وذلك يمنع من حمل السكوت على الخوف
وأيضا فلأن بعضهم خالف البعض في المسائل التي حكيناها ولو كان
هناك خوف يمنعهم من إظهار ما في قلوبهم لما وقع ذلك
فثبت أن سكوتهم كان عن الرضا وذلك يوجب كون القياس حجة وإلا لكانوا مجمعين على الخطأ وأنه غير جائز هذا تحرير الأدلة
فإن قيل لا نسلم ذهاب أحد من الصحابة إلى القول بالقياس والوجوه الأربعة المذكورة لا يزيد رواتها على المائة والمائتين وذلك لا يفيد القطع بالصحة لاحتمال تواطؤ هذا القدر على الكذب كيف والأحاديث التي يتمسك بها أهل الزمان في المسائل الفقهية مشهورة فيما بين الأمة إلا أن روايتها في الأصل لما انتهت إلى الواحد والإثنين لا جرم لم نقطع به فكذا هاهنا
فإن قلت الأمة في هذه الروايات على قولين
منهم من قبلها واعترف بدلالتها على القياس
ومنهم من اشتغل بتأويلها وذلك يدل على اتفاقهم على قبولها
قلت قد مر غير مرة أن هذا الطريق لا يفيد الجزم بصحتها
سلمنا صحة هذه الروايات لكن لا نسلم دلالتها على ذهابهم إلى القول بالقياس والعمل به
وأما الوجه الأول وهو قول عمر رضى الله عنه إعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك
قلنا التمسك إما أن يكون بقوله اعرف الأشباه والنظائر أو بقوله قس الأمور برأيك
أما الأول فلا حجة فيه لأن الله تعالى لما نص على حكم كل جنس ونوع وجب على المستدل معرفة الأشباه والنظائر لئلا يخرج منه ما هو من جنسه ولا يدخل فيه ما هو من غير جنسه وقد يشتبه الشيء بالشيء فلا بد من التأمل الكثير ليعرف أنه من جنسه أو من غير جنسه
وأما الثاني وهو قوله قس الأمور برأيك فلا يدل أيضا على الغرض لأن القياس في أصل اللغة عبارة عبارة عن التسوية فقوله قس الأمور برأيك معناه اعرض الأشيا على فكرتك وتأملك لأن التفكير في الشيء لا معنى له إلا استحضار علوم أو ظنون ليتوصل بها إلى تحصيل علوم أو ظنون فالمتفكر كأنه يريد التسوية بين المطلوب المجهول وبين المقدمات المعلومة ليصير المجهول معلوما
وهذا التأويل متعين لأن الرأى هو الروية فقوله قس الأمور برأيك معناه سو الأشياء برويتك وتسوية الأشياء بالروية ليست إلا ما ذكرنا فيرجع حاصل الأمر إلى أنه أمره بأن لا يحكم بمجرد التشهى والتمني بل بالاستدلال والنظر وذلك ليس من القياس الشرعي في شيء
سلمنا أن المراد منه الأمر بتشبيه الفرع بالأصل لكن يحتمل أن يكون المراد التشبيه في ثبوت ذلك الحكم وأن يكون المراد
منه التسوية في أنه كما لا يثبت حكم الأصل إلا بالنص فكذا حكم الفرع لا يثبت إلا بالنص فلم قلت إن الاحتمال الأول أولى من الثاني
وأما الوجه الثاني وهو تشبيه ابن عباس قلنا لم قلت إن المراد أنه جمع بين الأمرين بعلة قياسية
ولم لا يجوز أن يكون ذلك لأجل أنه كما سمى النافلة بالابن مجازا واكتفى بهذا الاسم المجازي في اندراج النافلة تحت عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم
وكذلك سمى الجد أبا مجازا حتى يكفى هذا في اندراجه تحت عموم قوله تعالى وورثه أبواه
والذي يؤكد هذا الاحتمال أن ابن
عباس نسب زيدا إلى مفارقة التقوى وتارك القياس لا يكون كذلك بل تارك النص يكون
كذلك وإنما يكون زيد تاركا للنص لو كان الأمر على ما قلنا
وأما الوجه الثالث فالكلام عليه
أنه ألا يجوز أن يقال إن ذهاب كل واحد إلى ما ذهب إليه في تلك المسائل كان لتمسكه بنص ظنه دليلا على قوله سواء أصاب في ذلك الظن أو أخطأ فيه
قوله لو كان كذلك لأظهروا ذلك النص ولاشتهر ولنقل ولوصل إلينا فلما لم يصل إلينا علمنا عدمه
قلنا هذه المقدمات بأسرها ممنوعة
قوله علمنا بالضرورة شدة تعظيمهم لنصوص الرسول عليه الصلاة و السلام ويمتنع ممن هذه حاله أن يحكم بحكم لأجل
نص ثم أنه لا يذكره
قلنا لا نسلم أن شدة تعظيمهم للنص يقتضى إظهار النص الذي لأجله ذهبوا إلى ذلك القول
بيانه أن شدة التعظيم إنما تقتضى إظهار النص عند الحاجة إلى إظهاره وهم ما احتاجوا إليه لأن الحاجة إما أن تكون عند المناظرة أو مع المستفتى
والأول باطل لأنهم لم يجتمعوا في محفل لأجل المناظرة في تلك المسائل وما كانت عادتهم جارية بالاجتماع على المناظرات والمجادلات
وأما المستفتى فلا فائدة من ذكر الدليل معه
سلمنا أن شدة تعظيمهم للنص تقتضى إظهار النص ولكن بشرط أن يكون السامع بحيث يمكنه الانتفاع به ولم يوجد هذا الشرط هناك لأنه إذا روى ذلك النص كان ذلك النص خبر واحد في حق السامع وخبر الواحد ليس بحجة فلا فائدة إذا في إظهار هذا النص
سلمنا أنه يجب إظهاره ولكن إذا كان النص جليا أو مطلقا سواء كان جليا أو خفيا
الأول مسلم والثاني ممنوع
بيانه أن الإنسان إنما يدعوه الداعي إلى إظهار دليل مذهبه إذا كان ذلك الدليل ظاهرا قويا
أما إذا كان خفيا فقد لا يدعوه الداعي إلى إظهاره وبالجملة فأنتم المستدلون فعليكم إقامة الدلالة على ان يجب إظهاره سواء كان قويا أو ضعيفا
سلمنا ما ذكرتموه لكن نعارضه فنقول لو كان ذهابهم إلى مذاهبهم لأجل القياس لوجب عليهم إظهاره ولكن لم يقل عن أحد من الصحابة القياس الذي لأجله ذهب إلى ما ذهب إليه
فإن قلت الفرق أن القياس لا يجب اتباع العالم فيه
والنص يجب اتباعه فيه
قلت القياس إذا كان ظاهرا جليا فلا نسلم أنه لا يجب الاتباع فيه ولولا ذلك لما حسنت المناظرة فيه بين القائسين
سلمنا أنهم لو تمسكوا بالنصوص لأظهروها فلم قلت إنهم لو أظهروها لاشتهر فإن ذلك ليس من الوقائع العظام التي يمتنع أن لا تتوفر الدواعى على نقلها
فأن قلت لما توفرت دواعيهم على نقل مذاهبهم مع أنه لا فائدة فيها فلأن تتوفر دواعيهم على نقل تلك الأدلة مع ما فيها من الفوائد كان أولى
قلت إنا لم نقل إن الأمور التي لا تكون عظيمة يمتنع نقلها حتى يكون ما ذكرتموه لازما علينا بل قلنا إنه لا يجب نقلها ولا يمتنع أيضا
سلمنا أنه من الوقائع العظيمة لكن لم قلت إنه يجب نقله والدليل عليه أن معجزات الرسول صلى الله عليه و سلم على جلالة قدرها وأمر الإقامة في الأفراد والتثنية على نهاية ظهورها لم ينقله إلا الواحد والإثنان وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن لا ينقله ذلك الواحد أيضا
سلمنا أنها لو اشتهرت لنقلت لكن لا نسلم أنها ما نقلت
قوله لو نقلت لعرفناها
قلنا إما أن تدعى أن كل ما نقل عن الرسول صلى الله عليه و سلم وجميع أصحابه فلا بد وأن تعلمه أنت أو تدعي أنه لا بد وأن يوجد في زمانك من يعلمه
أما الأول فلا يقول به إنسان سليم العقل
وأما الثاني فمسلم ولكن كيف عرفت أنه ليس في زمانك من يعلم تلك النصوص فإن كل أحد إنما يعلم حال نفسه لا حال غيره
سلمنا أنه لو نقل لعرفه كل واحد منا لكن لا نسلم أنا لا نعرفه فلنتكلم في مسألة الحرام فنقول أما من ذهب إلى كونه يمينا فيحتمل أنه إنما ذهب إليه استدلالا بقوله تعالى
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وانه عليه الصلاة و السلام حرم على نفسه مارية القبطية فأنزل الله تعالى هذه الآية وسماه يمينا
ومن ذهب إلى أنه لا اعتبار به تمسك بقوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل لكم والنهي يدل على الفساد أو بالبراءة الأصلية
ومن ذهب إلى أنه للطلقات الثلاث زعم أنه قد يجعل كناية عن الطلقات الثلاث فوجب تنزيله على أعظم أحواله وهو الطلقات الثلاث ثم أدخله تحت قوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
ومن ذهب إلى أنه للطلقة
الواحدة نزله على أقل أحواله
ومن جعله ظهارا جعله كناية عنه والكنايات في اللغة ليست عبارة عن القياس الشرعي
سلمنا أن قولهم بتلك المذاهب ليس للنص فلم قلتم إنه لا بد وأن يكون للقياس فما الدليل على نفى الواسطة
ثم إنا نتبرع بذكر الوسائط منها تنزيل اللفظ على أقل المفهومات أو على الأكثر
ومنها استصحاب الحال
ومنها المصالح المرسلة الخالية عن شهادة الأصول
ومنها الاستقراء والفرق بينه وبين القياس أن الاستقراء عبارة عن إثبات الحكم في كلى لثبوته في بعض جزئياته والقياس عبارة عن إثباته في جزئي لأجل ثبوته في جزئي آخر
ومنها أنه كان من مذهبه أن مجرد قوله حجة ومستند ذلك الوهم إلى أن قول بعض الأنبياء حجة فيكون قول هذا العالم حجة
بيان الأول
قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه أضاف التحريم إليه
بيان الثاني
قوله عليه الصلاة و السلام علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل فهذه الشبهة تقتضى
أن يكون مجرد قول العالم حجة فلعل هذه الشبهة خطرت ببالهم ومنها الإجماع
فإن قلت حصول الإجماع في محل الخلاف محال
قلت المقصود من ذكر الإجماع بيان ثبوت الواسطة بين النص والقياس في الجملة
فهذا هو الكلام على الوجه الثالث
وأما الوجه الرابع وهو أن الصحابة قالت بالرأى والرأى هو القياس فنقول لا نسلم أن الرأى هو القياس والدليل عليه وجوه
الأول
أنه يقال رأى يرى رؤية ورأيا فدل هذا على انه مرادف للرؤية فإذا ثبت ذلك وجب أن لا يكون حقيقة في القياس دفعا للاشتراك
وإذا ثبت أنه ما كان في أصل اللغة للقياس وجب أن لا يكون في عرف الشرع له لأن النقل خلاف الأصل
الثاني لو كان الرأى اسما للقياس لكان اللفظ المشتق منه دليلا على القياس وكان يجب أن يكون قولنا فلان يرى كذا معناه أنه يقيس ومعلوم أن ذلك باطل لأن من يذهب إلى الرؤية والصفات وخلق الأعمال يجوز أن يحكى عن نفسه أنى أرى القول بهذه الأشياء وعمن يشاركه في المذهب إنه يرى القول بها
الثالث أنكم رويتم عن أبي بكر رضى الله عنه أنه قال في الكلالة أقول فيها برأيي ومعلوم أن تفسير اللفظة اللغوية لا يكون بالقياس
فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن الرأى ليس اسما للقياس
وأما الذي تمسكتم به من أنه يقال أقلت هذا عن رأيك أو عن النص
قلنا أقصى ما في الباب أن يدل هذا الاستعمال على أن الرأى غير النص لكن من أين يدل على أنه لما كان غير النص وجب أن يكون قياسا
بيانه
أن النص هو اللفظ الدال على الحكم دلالة ظاهرة جلية فما لا يكون كذلك لا يكون نصا فلا يلزم من كون الرأى خارجا عن النص أن لا يكون ذلك الاستدلال لفظيا لاحتمال أنه لما كان خفيا لا جرم لا يسمى بالنص
سلمنا أن مسمى الرأى ليس هو النص فلم قلتم إنه هو القياس وما الدليل على هذا الحصر
فهذا هو الكلام المختصر على الوجوه الأربعة المذكورة في تقرير المقدمة الأولى
سلمنا أن بعض الصحابة قال بالقياس أو عمل به فلم قلت أن أحدا منهم ما أنكره
قوله لو أنكروه لاشتهر ولنقل ولوصل إلينا
قلنا الكلام على هذه المقدمات قد مر
والذي نقوله الآن إنا لا نسلم أنه ما وصل ذلك الإنكار إلينا فإنه نقل عنهم تارة إنكار الرأى وأخرى إنكار القياس وأخرى ذم من أثبت الحكم لا بالكتاب والسنة روى عن أبي بكر رضى الله عنه أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي
وعن عمر رضى الله عنه إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا
وعنه رضى الله عنه إياكم والمكايلة قيل وما المكايلة قال المقايسة
وعن شريح قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ من قبله قاض اقض بما في كتاب الله تعالى فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن جاءك ما ليس فيها فاقض بما أجمع عليه أهل العلم فإن لم تجد فلا عليك أن تقضي
وعن على لو كان الدين يؤخذ بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره
وروى عنه من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه
وهذا أيضا يروى عن عمر رضى الله عنه
وعن ابن عباس يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم
وقال إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرمه الله تعالى وحرمتم كثيرا مما حلل الله
وقال إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه و سلم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولم يقل بما رأيت
وقال لو جعل لأحدكم أن يحكم برأيه لجعل ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم ولكن قيل له وأن احكم بينهم بما أنزل الله
وقال إياكم والمقاييس فإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس
وعن ابن عمر رضى الله عنه السنة ما سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تجعلوا الرأى سنة للمسلمين
وعن مسروق لا أقيس شيئا بشيء أخاف أن تزل قدمي بعد ثبوتها
وكان ابن سيرين يذم القياس ويقول أول من قاس إبليس
وقال الشعبي لرجل لعلك من القياسيين
وقال إن أخذتم بالقياس أحللتم الحرام وحرمتم الحلال
فثبت بهذه الروايات تصريح الصحابة والتابعين بإنكار الرأى والقياس
فإن قلت هؤلاء الذين نقلت عنهم المنع من القياس هم الذين دللنا على ذهابهم إلى القول به فلا بد من التوفيق وذلك بأن نصرف الروايات المانعة من القياس إلى بعض أنواعه وذلك حق لأن العمل بالقياس لا يجوز عندنا إلا بشرائط مخصوصة
قلت هب أن الذين نقلنا عنهم المنع من القياس هم الذين دللتم على أنهم كانوا عاملين به إلا أنا نقلنا عنهم التصريح بالرد والمنع على الإطلاق من غير تقييد بصورة خاصة وانتم ما نقلتم عنهم التصريح بالقول بل رويتم عنهم أمورا ثم دللتم بوجوه دقيقة غامضة على أن تلك الأمور دالة على قولهم بالقياس ومعلوم أن التصريح بالرد أقوى مما ذكرتموه فكان قولنا راجحا
سلمنا عدم الترجيح من هذا الوجه لكن كما أن التوفيق الذي ذكرتموه ممكن فهاهنا توفيق آخر وهو أن يقال إن بعضهم كان قائلا بالقياس حين كان البعض الآخر منكرا له ثم لما انقلب المنكر مقرا انقلب المقر أيضا منكرا
وعلى هذا التقدير يكون كل واحد منهم مادحا للقياس وذاما له من غير تناقض مع أنه لا يحصل الإجماع
سلمنا أن بعض الصحابة قال بالقياس وأن أحدا منهم
ما أظهر الإنكار فلم قلتم يحصل الإجماع
وبيانه أن السكوت قد يكون للخوف والتقية
قوله القول بالقياس ليس سببا لنفع دنيوى فكيف يحصل الخوف من إنكار الحق فيه
قلنا لا نسلم عدم الخوف هناك
قال النظام في هذا المقام الصحابة ما اجمعوا على القياس بل القائل به قوم معدودون وهم عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبى وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى وأناس قليل من أصاغر الصحابة والباقون ما كانوا عاملين به ولكن لما كان فيهم عمر وعثمان وعلى وهؤلاء لهم سلطان ومعهم الرغبة والرهبة شاع ذلك في الدهماء وانقادت لهم العوام
فجاز للباقين السكوت على التقية لأنهم قد علموا أن إنكارهم غير مقبول
قال والذي يدل عليه أنه
قال في الفتيا عبد الله بن عباس والعباس أكبر منه ولم يقل في الفتيا شيئا من غير عجز ولا عى ولا غيبة عن شيء شهده أبنه
وقال في الفتيا عبد الله بن الزبير والزبير أعظم منه ولم يقل فيه شيئا
وكان أبو عبيدة ومعاذ بن جبل بالشام فقال معاذ ولم يقل أبو عبيدة مع أن أبا عبيدة أعظم منه فإنه قال عليه الصلاة و السلام
أبو عبيدة أمين هذه الأمة
وكيف يقال كان الخوف زائلا وابن عباس قال هبته وكان الله مهيبا
وأيضا فإن الرجل العظيم إذا أختار مذهبا فلو أن غيره أبطل ذلك المذهب عليه فإنه يشق عليه غاية المشقة ويصير ذلك سببا للعداوة الشديدة
قوله لو كان الخوف مانعا من المخافة لما خالف بعضهم بعضا في مسألة الجد والحرام
قلنا القياس أصل عظيم في الشرع نفيا وإثباتا فكان النزاع فيه أصعب من النزاع في فروع الفقه ولذلك نرى في
المختلفين في مسألة القياس يضلل بعضهم بعضا والمختلفين في الفروع لا يفعلون ذلك
سلمنا أن أسباب الخوف ما كانت ظاهرة ولكن أجمع المسلمون على أنهم ما كانوا معصومين فكيف يمكننا القطع باحترازهم عن كل ما لا ينبغي غاية ما في الباب حسن الظن بهم ولكن ذلك يكفى في القطعيات
سلمنا زوال الخوف ولكن لعلهم سكتوا لأنه ما ظهر لهم كون القياس حقا ولا باطلا فكان فرضهم السكوت
أو أنهم عرفوا كونه خطأ لكنهم اعتقدوا أنه من الصغائر فلا يجب الإنكار على العامل به ولأن كل واحد منهم اعتقد في غيره أنه أولى بإظهار الإنكار
سلمنا أنهم بأسرهم رضوا لكن حصل الرضا دفعة واحدة أو لادفعة واحدة
الأول
مما لا يعرفه إلا الله تعالى لأنهم ما جلسوا في محفل واحد قاطعين بصحته دفعة واحدة
والثاني لا يفيد الإجماع
لأنه ربما كان الأمر بحيث لما صار البعض راضيا بقلبه صار الآخر متوقفا فيه أو منكرا عليه بالقلب وذلك يمنع من انعقاد الإجماع
فإن قلت هذا الاحتمال يمنع من انعقاد الإجماع
قلت لا نسلم فإن أهل الإجماع كانوا قليلين في زمان الصحابة وكان يمكنهم أن يجتمعوا في محفل واحد ويقطعوا بالحكم فيكون ذلك الإجماع خاليا عن هذا الاحتمال
أما إذا لم يجتمعوا في محفل واحد فإذا سئل بعضهم فأفتى به ثم أنه سئل إنسان آخر في بلد آخر فلعل المفتى الأول رجع عن فتواه حينما أفتى به المفتى الثاني وحينئذ لا يتم الإجماع
وهذا سؤال أهل الظاهر ولهذا قالوا لا حجة إلا في إجماع الصحابة
سلمنا انعقاد الإجماع على قياس ما لكن لم ينقل إلينا أنهم أجمعوا على النوع الفلانى من القياس أو على كل أنواعه ولم يلزم من انعقاد الإجماع على صحة نوع انعقاده على صحة كل نوع
فإذن لا نوع إلا ويحتمل أن يكون النوع الذي أجمعوا عليه هو هذا النوع وأن يكون غيره
وإذا كان كذلك صار كل أنواعه مشكوكا فيه فلا يجوز العمل بشيء منه فإن قلت الأمة على قولين
منهم من أثبت القياس
ومنهم من نفاه وكل من أثبته فقد أثبت النوع الفلانى مثلا فلو أثبتنا قياسا غير هذا النوع كان خرقا للإجماع
قلت لا نسلم أن كل من أثبت نوعا من القياس أثبت نوعا معينا منه لأن القياس إما أن يكون مناسبا أو لا يكون وكل واحد من القسمين مختلف فيه
أما المناسب فرده قوم قالوا لأن مبناه على تعليل أحكام الله تعالى بالحكم والأغراض وأنه غير جائز
وأما غير المناسب فقد ردة الأكثرون
فثبت أنه ليس هاهنا قياس مقبول بإجماع القايسين
سلمنا إنعقاد إجماع القائسين على نوع واحد ولكن لم لا يجوز أن يكون ذلك هو قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف
وما إذا نص الله تعالى على العلة فإن هذا القياس عندنا حجة
سلمنا انعقاد الإجماع على جواز العمل بالقياس في زمان الصحابة فلم يجوز في زماننا
والفرق أن الصحابة لما شاهدوا الرسول صلى الله عليه و سلم والوحى فربما عرفوا بقرائن الأحوال أن المراد من الحكم الخاص بصورة معينة رعاية الحكمة العامة فلا جرم جاز منهم التعبد به
وأما غير الصحابة فإنهم لما لم يشاهدوا الوحى والرسول والقرائن لم يكن حالهم كحال الصحابة
فإن قلت كل من جوز العمل بالقياس للصحابة جوزه لغيرهم
قلت كيف يقطع بأنه ليس في فرق الأمة على كثرتها أحد يقول بهذا الفرق مع وضوحه غايته أنا لا نعرف أحدا قاله لكن عدم العلم بالشيء لا يقتضى العلم بعدمه
والجواب أن أصحابنا ذهبوا إلى أن الروايات المذكورة في اختلافهم في مسألة الجد والحرام والمشركة والإيلاء والخلع
وتقدير الحد بشرب الخمر وقياس العهد على العقد وقول الصحابة على بالتشبيه والرأى وما نقل من الأحاديث في القياس كخبر معاذ وابن مسعود وخبر الخثعمية والسؤال عن قبلة الصائم وأمر عمر أبا موسى بالقياس وقول ابن عباس بالتشبيه
قد بلغ مجموعها إلى حد التواتر فإن من خالط أهل الأخبار وطالع كتبهم قطع بصحة شيء من هذه الأخبار فإنها بأسرها يمتنع أن تكون كذبا وأى واحد منها صح صح القول بالقياس
وهذا الذي قاله الأصحاب جيد إلا أن الخصم لو كابر وقال لا أسلم خروج هذا المجموع عن كونه خبر واحد
قلنا هب أنه كذلك فأيش يلزم
قوله المسألة علمية قطعية فلا يجوز إثباتها بدليل ظني
قلنا لا نسلم أنها قطعية بل هي عندنا ظنية لأن هذه المسألة عملية والظن قائم مقام العلم في وجوب العلم ألا ترى أنه لا فرق بين أن يعلم بالمشاهدة وجود الغيم الرطب المنذر بالمطر الذي يجب التحرز منه وبين أن يخبر بوجود مثل هذا الخيم مخبر لمن لا يمكنه مشاهدة الغيم في أنه يلزمه التحرز منه فكذا هاهنا لا فرق بين أن يتواتر النقل عن الشرع في أنا مأمورون بالقياس وبين أن يخبر نا به من يظن صدقه في وجوب العمل بالقياس وإن لم نعلم صدق المخبر بذلك وهذا الجواب قاطع للشغب بالكلية
قوله على الوجه الأول لا يجوز أن يكون المراد من قول عمر اعرف الأشباه والنظائر الأمر بمعرفة
ماهية كل جنس لئلا يدخل تحت النص المذكور في ذلك الجنس ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه
قلنا مقدمة هذا الكلام ومؤخرته تبطل هذا الاحتمال وهو قول عمر رضى الله عنه الفهم عندما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ولا سنة نبيه ثم اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك عند ذلك ثم اعمد إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى فمن تأمل هذا الكلام عرف أنه صريح في الأمر بالقياس الشرعي
وهو الجواب أيضا عن قوله لم لا يجوز أن يكون المراد منه تشبيه الفرع بالأصل في أنه لا يثبت حكمه إلا بالنص
قوله على الوجه الثاني لم لا يجوز أن يكون المراد منه
أنه لم لا يسمى الجد أبا مجازا حتى يدخل تحت قوله وورثه أبواه كما سمى النافلة ابنا حتى دخل تحت قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم
قلنا لا يجوز أن يكون إنكار ابن عباس على زيد لأجل امتناعه من المجاز في أحد الموضعين دون الثاني لأن حسن المجاز في أحد الموضعين لا يوجب حسنه في الموضع الثاني
وبتقدير التساوي في الحسن لكن القطع به في أحد الموضعين لا يوجب القطع به في الموضع الثاني
وإذا ثبت أن هذا الإنكار غير متوجه على التفرقة في إطلاق الاسم المجازى ثبت أنه متوجه على التفرقة في الحكم الشرعي فيكون ذلك تصريحا بالقياس الشرعي
قوله لو كان المراد هو الحكم الشرعي لما نسبه إلى مفارقة التقوى
قلنا لعل هذا القياس كان جليا عند ابن عباس وكان من مذهبه أن الخطأ في مثل هذا القياس يقدح في التقوى
وأيضا فذلك محمول على المبالغة
قوله على الوجه الثالث لم قلت إن مبالغتهم في تعظيم الرسول صلى الله عليه و سلم يوجب إظهار النص
قلنا استقراء العرف يشهد به فإن من حكم بحكم غريب يخالفه فيه جمع يوافقونه على تعظيم شخص معين ووجد ذلك الإنسان حجة من قول ذلك الإنسان العظيم فإنه لابد أن يذكر لهم ذلك القول ويصرح به
قوله إنما يذكر عند الحاجة إلى ذكره
قلنا والحاجة إلى ذكره حاصلة مطلقا لأن من يعتقد أن مذهبه ثابت بالنص فلا بد أن يعلم أن مخالفه إنما خالفه إما لا لطريق أو
لطريق مرجوح بالنسبة إلى طريقه أو مساوله أو راجح عليه وعلى التقديرين الأولين كان مخالفه مخالفا للنص
وعلى التقدير الثالث يكون فرض كل واحد منها التوقف فتكون الفتوى بأحدهما محظورا
وعلى التقدير الرابع يكون مخالفا للنص
فإذن من أثبت مذهبه بالنص فإنه لا بد وأن يعتقد فيمن خالفه أو في نفسه كونه مخالفا للنص لكن شدة إنكارهم على مخالفة النص تقتضي شدة احترازهم عنها ولا طريق إلى ذلك الاحتراز إلا بذكر ذلك النص
فثبت أن شدة تعظيمهم للرسول صلى الله عليه و سلم توجب عليهم أن يذكروا نصوصه على الإطلاق
وبهذا ظهر الجواب عن قوله أنه لا يجب ذكر النصوص الخفية لأن الدليل الذي ذكرناه مطرد في الكل
قوله لو أثبتوا مذاهبهم بالقياس لوجب عليهم أن يذكروه
قلنا الفرق من وجوه
أحدها أن إنكارهم على مخالف النص أقوى من إنكارهم على مخالف القياس فلم يلزم من ترك أقل الانكارين ترك أعظمها
وثانيها أن الخواطر مستقلة بمعرفة العلل القياسية فلا يجب التنبيه عليها وهي غير مستقلة بمعرفة النصوص وذلك يقتضى وجوب التنبيه عليها
فإن قلت لو لم يجب التنبيه على العلل القياسية لما حسنت المناظرات
قلت ليس كل ما لا يجب لا يحسن
وثالثها أن النصوص يجب اتباعها فيجب نقلها والأقيسة لا يجب
اتباعها فلا يجب نقلها لأن عندنا كل مجتهد مصيب
ورابعها أن النصوص يمكن الإخبار عنها على كل حال وأما الأمارات فقد يتعذر التعبير عنها وإن كانت مفيدة للظن مثل الأمارات في قيم المتلفات وأروش الجنايات ولذلك لا يتمكن المقوم من أن يذكر أمارة ملخصة في تقدير القيمة بالقدر المعين
فإن قلت أليس أن فقهاء هذا الزمان يعبرون عن هذه الأمارات
قلت المتأخر في كل علم يلخص ما لم يلخصه المتقدم
سلمنا أنه يجب عليهم ذكر تلك الأقيسة لكن يجب ذكرها صريحا أو تنبيها
الأول ممنوع والثاني مسلم وهاهنا قد نبهوا على العلل بالإشارة إلى الأصول التي ذكروها
بيانه أنهم اتفقوا على أنه حكم قوله أنت على حرام
أما أن يكون حكمه حكم الطلاق أو الظهار أو اليمين وعلة ذلك ظاهرة وهى أن قوله أنت على حرام لفظ موضوع للتحريم فيؤثر فيه إذا توجه إلى الزوجة كهذه المسائل
ثم إن كل واحد منهم رجح الأصل الذي اختاره
فمنهم رجح الاحتياط فجعله طلاقا ثلاثا
ومنهم من رجح بالمتيقن فجعله طلقة واحدة
ومنهم من جعله ظهارا لمشابهته إياه في اقتضاء التحريم ومباينته لصرائح الطلاق وكناياته ثم جعل كفارته كفارة الظهار أخذا بالاحتياط لأنها أغلظ من كفارة اليمين
ومنهم من رجح بأن كفارة اليمين أقل الكفارات فيوجبها أخذا بالأقل
فظهر أن ذكر هذه الأصول منبه على كيفية قياساتهم
قوله لم قلت لو أظهروا تلك النصوص لوجب اشتهارها
قلنا لأن هذه المسائل من المسائل التي يكثر وقوعها فكانت الحاجة إلى معرفة حكم الله تعالى فيها بالدليل شديدة وما كان كذلك فإن الدواعى تتوفر على حفظ النصوص الواردة فيها فهذا إن لم يفد القطع فلا أقل من الظن
قوله تدعى أن تلك النصوص لو نقلت لعرفتها أنت أو لعرفه أحد ممن في هذا الزمان
قلنا ندعى قسما ثالثا وهو أن يكون مشهورا في الكتب بحيث يجده كل من حاول طلبه
قوله من ذهب إلى أنه يمين تمسك بقوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
قلنا أن قوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك لا يدل على أنه إذا حرم فماذا
حكمه ثم إن دل فإنما يدل على مذهب مسروق
وأما قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فنقول ليس في الآية إلا أنه عليه الصلاة و السلام حرم ما أحل الله له فيجوز أن يكون قد حرمه بلفظ اليمين بأن كان قد حلف بأنه لا يقرب مارية بل هذا أولى لأن اليمين القسم بالله ولا شبهة في أن قوله أنت على حرام ليس قسما بالله
فثبت أن هذه الآية لا دلالة فيها على حكم هذه المسألة
وأيضا فلو نزلت هذه الآية بسبب قوله لماريه أنت على حرام لكان ذلك نصا في الباب وذلك يمنع من ذهاب كل واحد منهم في هذه المسألة إلى قول آخر لما بينا أن شدة إنكارهم على من خالف نصوصه يمنع منه
قوله من حمله على الطلقات الثلاث جعله ككنايات الطلاق
قلنا لاشك أن قوله أنت على حرام ليس من صرائح الطلاق وما أجمعوا على أنه من كنايات الطلاق
فإذن لابد وأن يقال إن حكم هذا الكلام مثل حكم الصرائح والكنايات وهذا التشبيه نفس القياس بل لا نزاع في أنه بعد ثبوت هذه المشابهة يندرج تحت قوله إذا طلقتم النساء وقوله الطلاق مرتان
قوله من حمله على الطلقة الواحدة فإنما حمله عليها أخذا بالمتيقن
قلنا هذا إنما يثبت بعد أن نجعله من صرائح الطلاق أو كناياته
وحينئذ فلا بد فيه من القياس
قوله من حمله على الظهار فقد أجراه مجرى الظهار
قلنا إن أردتم به أنه أجراه مجرى الظهار في الحكم فهذا هو القياس
وإن أردتم غيره فبينوه
قوله إن مسروقا تمسك بالبراءة الأصلية
قلنا لا نسلم بل قاسه على قصتة من ثريد فإنه حكى عنه أنه قال لا فرق عندي بينه وبين قصعة من ثريد
وأيضا فإن مسروقا كان من التابعين فإما أن يقال إنه عاصر الصحابة حين اختلفوا في هذه المسألة أو ما عاصرهم في ذلك الوقت
فإن كان الأول كانت الصحابة تاركين للبراءة الأصلية بسبب
القياس لما بينا أنهم ما ذهبوا إلى مذاهبهم لأجل النص وذلك يقتضى عمل بعض الصحابة بالقياس ولا مطلوب في هذا المقام إلا ذلك
وإن كان الثاني كان إجماعهم حجة عليه
قوله هب أنهم ما ذهبوا إلى تلك المذاهب لأجل النص فلم قلت ذهبوا إليها للقياس
قلنا لأن كل من قال الصحابة لم يرجعوا في تلك الأقاويل إلى البراءة الأصلية ولا إلى النصوص الجلية أو الخفية قال إنهم عملوا فيها بالقياس هذا تمام الكلام في الوجه الثالث
قوله على الوجه الرابع إن الرأى في أصل اللغة ليس للقياس
قلنا هذا مسلم لكنا ندعى أنه في عرف الشرع اختص بالقياس وهذا وإن كان خلاف الأصل لكن الدليل قام عليه
فإنكم رويتم عنهم كلاما كثيرا في ذم الرأى وقد ساعدنا خصومنا على أن المراد منه ذم القياس فعلمنا أن عرف الشرع يقتضي تخصيص اسم الرأى بالقياس وهذا تمام الكلام في المقدمة الأولى
قوله إنهم صرحوا بالإنكار
قلنا نعم ولكن التوفيق ما ذكروا
قوله روايات الإنكار صريحة وروايات الاعتراف غير صريحة
قلنا هب إنها غير صريحة لفظا لكنها صريحة بحسب الدلالة المذكورة فلم قلت إنه يبقى ما ذكرتموه من الترجيح
قوله لعل المنكر انقلب مفردة وبالعكس
قلنا لو وقع ذلك لاشتهر لأنه من الأمور العجيبة فحيث لم يشتهر دل على أنه لم يقع
قوله لعلهم سكتوا خوفا
قلنا استقراء حال الصحابة يفيد ظنا غالبا بشدة انقيادهم للحق وأما قدح النظام فيهم فقد سبق الجواب عنه في باب الأخبار
قوله يجوز أن يكون سكوتهم لعدم علمهم بكونه حقا أو باطلا
قلت هب أنهم كانوا متوقفين فيه في أول الأمر ولكن الظاهر أن بعد انقضاء الأعصار يظهر لهم كونه حقا أو باطلا
قوله لعل كل واحد منهم اعتقد أن غيره أولى بالإنكار
قلنا لا بد وان يكون واحد منهم أولى بذلك أو يكون الكل في درجة واحدة وكيفما كان فأجماعهم على ترك الإنكار إجماع على الخطأ
قوله حصل الرضا دفعة أولا دفعة
قلنا الأصل في كل ثابت بقاؤه على ما كان
قوله لا نعلم أنهم بأي أنواع القياس تمسكوا
قلنا الإجماع الظاهر حاصل في أن القياس المناسب حجة
قوله لم قلت إنه يلزم من جواز العمل بالقياس للصحابة جوازه لنا
قلنا لا نعرف أحدا قال بالفرق فيكون الإجماع حاصلا ظاهرا فهذا تمام الكلام في هذه الطريقة
وإنما استقصينا القول فيها جوابا وسؤالا لأنا رأينا الأصوليين يعولون عليها في كثير من مسائل هذا العلم وقد ذكرناها أيضا في مواضع كثيرة من هذا الكتاب فأردنا أن نعرف مقدار قوتها
وقد ظهر أنها لو أفادت شيئا ما أفادت إلا ظنا ضعيفا وأنه ليس الأمر كما يعتقده الجمهور من أنه يفيد إجماعا قاطعا
المسلك السادس
تقرير الإجماع على وجه آخر فنقولنعلم بالضرورة اختلاف الصحابة في المسائل الشرعية
فإما أن يكون ذهابهم إلى ما ذهبوا إليه لا لطريق فيكون ذلك إجماعا على الخطأ وأنه غير جائز
أو لطريق
وهو إما أن يكون عقليا أو سمعيا
لا يجوز أن يكون عقليا لأن العقل لا دلالة فيه إلا على البراءة الأصلية ويستحيل أن يكون قول واحد من المختلفين قولا بالبراءة الأصلية
فثبت أنه كان سمعيا
وهو إما أن يكون قياسيا أو نصا أو غيرهما
أما القياس فهو المطلوب
وأما النص فغير جائز لأن مخالف النص يستحق العقاب العظيم لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ونحن نعلم بالضرورة أن المختلفين منهم في المسائل الشرعية ما كان كل واحد منهم يعتقد في صاحبه كونه مستحقا للعقاب العظيم بسبب تلك المخالفة
وأما الذي ليس بنص ولا قياس فباطل لأن كل من قال من الأمة إنهم لم يتمسكوا في تقرير أقوالهم بشيء من النصوص الجلية أو الخفية ولا بالبراءة الأصلية قال إنهم تمسكوا بالقياس فلو قلنا إنهم قالوا بتلك الأقاويل بشيء غير هذين القسمين كان ذلك قولا غير قولى كل الأمة وهو باطل
فهذه الدلالة وإن كان يتوجه عليها كثير مما توجه على الوجه
الذي قبله إلا أن كثيرا من تلك الأسئلة ساقط عنها
المسلك السابع
وهو المعقول أن القياس يفيد ظن الضرر فوجب جواز العمل به بيان الوصف أن من ظن أن الحكم في الأصل معلل بكذا وعلم أو ظن حصول ذلك الوصف في الفرع وجب أن يحصل له الظن بأن حكم الفرع مثل حكم الأصل ومعه علم يقيني بأن مخالفة حكم الله تعالى سبب العقاب فتولد من ذلك الظن وهذا العلم ترك العمل به سبب للعقاب فثبت أن القياس يفيد ظن الضرر
بيان التأثير أن العاقل يعلم ببديهة عقله أنه لا يمكنه الخروج عن النقيضين ولا يمكنه الجمع بينهما بل يجب لا محالة
ترجيح أحدهما على الآخر ونعلم بالضرورة أن ترجيح ما غلب على ظنه خلوه عن المضرة على ما غلب على ظنه اشتماله على المضرة أولى من العكس ولا معنى لجواز العمل بالقياس إلا هذا القدر
فإن قيل دليلكم مبني على إمكان ما يدل على أن الحكم في الأصل معلل بعلة
ثم على وجود ذلك الوصف في الأصل
ثم على إمكان ما يدل على حصول ذلك الوصف في الفرع
ثم على أنه يلزم من حصول ذلك الوصف في الفرع ظن حصول ذلك الحكم فيه
وتقرير هذه المقامات الخمس سيأتي في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى
سلمنا حصول هذا الظن فلم قلتم إن العمل به واجب قوله لأن ترجيح الخالى عن الضرر على المشتمل عليه متعين في بديهة العقل
قلنا هذا منقوض بما أنه لا يجب على القاضي أن يعمل بقول الشاهد الواحد إذا غلب على ظنه صدقه وأن يعمل في الزنا بقول الشاهدين إذا غلب على ظنه صدقهما
وبما إذا ظهرت مصلحة لا يشهد باعتبارها حكم شرعي ألبتة
وبما إذا ادعى الرجل الذي غلب على الظن صدقه للنبوة
وبما إذا غلب على ظن الدهرى واليهودى أو النصراني والكافر قبح هذه الأعمال الشرعية فإن غلبة الظن حاصلة في هذه الصور ولا يجوز العمل بها
فإن قلت المظنة إنما تفيد الظن إذا لم يقم دليل قاطع على فسادها وفي هذه الصور قد قامت الدلالة على فسادها
فلا يبقى الظن
قلت فعلى هذا التقدير القياس إنما يفيد ظن دفع الضرر إذا لم يوجد دليل يدل على فساد القياس فيصير نفى ما يدل على فساد القياس جزءا من المقتضى لظن الضرر فعليكم أن تثبتوا أنه لم يوجد ما يدل على نفى القياس حتى يمكنكم ادعاء حصول ظن الضرر
وبعد المجاوزة عن النقض نقول متى يجب الاحتراز عن الضرر المظنون إذا أمكن تحصيل العلم به أم إذا لم يمكن
الأول ممنوع
فإن الشيء الذي أمكن تحصيل العلم به فالاكتفاء بالظن مع جواز كونه خطأ اقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا مع إمكان الاحتراز عنه وهو غير جائز بالاتفاق
والثاني مسلم
ولكن إنما يجوز الاكتفاء بالظن في الوقائع الشرعية إذا بينتم
أنه لا طريق إلى تحصيل العلم بها ألبتة وذلك إنما يصح لو ثبت أنه لم يوجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه و سلم ما يدل على احكام تلك الوقائع ولم يوجد في الزمان إمام معصوم يعرفنا تلك الأحكام فان بتقدير وجود أحد هذه الأمور كان تحصيل اليقين بالحكم ممكنا
سلمنا إنه لا طريق إلى تحصيل العلم بها لكن لما قلت أنه لم يوجد ما يقتضى ظنا هو أقوى من الظن الحاصل بالقياس فان بتقدير إمكان ذلك كان التعويل على القياس اكتفاء بأضعف الظنين مع القدرة على تحصيل الأقوى وأنه غير جائز
ثم نقول إن دل على ما ذكرتموه على صحة القياس فمعنا ما يدل على فساده وهو الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماع العترة والمعقول
أما الكتاب فقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والقول بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وأله وسلم
وقوله تعالى وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ولا تقف ما ليس
لك به علم والقول بالحكم في الفرع لأجل القياس قول بالمظنون لا بالمعلوم
وأيضا
قال الله تعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل الله والحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله تعالى
وأيضا قال الله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ما فرطنا في الكتاب من شيء فهذه الآية دالة على اشتمال الكتاب على الأحكام الشرعية بأسرها فإذن كل ما ليس في الكتاب وجب أن لا يكون حقا وعند ذلك نقول ما دل عليه القياس إن دل عليه الكتاب فهو ثابت بالكتاب لا بالقياس
وإن لم يدل عليه الكتاب كان باطلا
وأقوى ما تمسكوا به من الآيات قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا
وجه الاستدلال به أن في القياس الشرعي لا بد وأن يكون تعليل الحكم في الأصل وثبوت تلك العلة في الفرع ظنيا ولو وجب العمل بالقياس لصدق على ذلك الظن أنه أغنى من الحق شيئا وذلك يناقض عموم النفى
فإن قلت يشكل التمسك بهذه النصوص بالفتوى والشهادات وأمارات القبلة
قلت تخصيص العام في بعض الصور لا يخرجه عن كونه حجة
وأما السنة فخبران
الأولقوله عليه الصلاة و السلام تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب
وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا
الثاني
قوله عليه الصلاة و السلام تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام
فإن قلت خبر الواحد لا يعارض الدليل العقلى الذي ذكرناه
قلت الدليل الذي ذكرتموه هو أن القياس يفيد الضرر المظنون فيجب الاحتراز عنه ولا شك أن خبر الواحد يفيد الظن فإذا ورد في المنع من القياس أفاد ظن أن التمسك به سبب الضرر وذلك يوجب الاحتراز عنه
وأما إجماع الصحابة
فهو أنه نقل عن كثير منهم التصريح بذم القياس على ما تقدم بيانه ولم يظهر من أحد منهم الإنكار على ذلك الذم وذلك يدل على انعقاد الإجماع على فساد القياسفإن قلت هذا معارض بأنه نقل عنهم أنهم اختلفوا في مسائل مع أنه لا طريق لهم إلى تلك المذاهب إلا القياس
قلت ما ذكرناه أولى لأن التصريح راجح على ما ليس بتصريح
وأما إجماع العترة
فلأنا كما نعلم بالضرورةبعد مخالطة أصحاب النقل أن مذهب الشافعى رضى الله عنه وأبي حنيفة ومالك رحمهما الله القول بالقياس فكذا نعلم بالضرورة أن مذهب أهل البيت كالصادق والباقر إنكار القياس وقد تقدم في باب الإجماع أن إجماع العترة حجة
وأما المعقول فمن وجوه
الأوللو جاز العمل بالقياس لما كان الاختلاف منهيا عنه لكنه منهي عنه فالعمل بالقياس غير جائز
بيان الملازمة
أن العمل بالقياس يقتضى اتباع الأمارات وذلك يقتضى وقوع الاختلاف لا محالة ووقوع ذلك شاهد على صحة ما قلناه
بيان أنه لا تجوز المخالفة قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم
الثاني
أن الرجل لو قال اعتقت غانما لسواده فقيسوا عليه لم يعتق سائر عبيده السود فضلا عما إذا لم يأمر بالقياس
فإذا قال الله تعالى حرمت الربا في البر فكيف يجوز القياس عليه فهذا كله كلام من لم يمنع القياس عقلا
أما المانعون منه عقلا فقد ذكرنا أن منهم من خص ذلك المنع بهذا الشرع
أما المانعون منه عقلا فقد ذكرنا أن منهم من خص ذلك المنع بهذا الشرع
ومنهم من منعه في كل الشرائع
أما الأول فهو قول النظام واحتج عليه بأن مدار هذا الشرع على الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات وذلك يمنع من القياس في هذا الشرع
بيان الأول في صور
إحداهما أنه جعل بعض الأزمنة والأمكنة أشرف من بعض مع استواء الكل في الحقيقة قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر وفضل الكعبة على سائر البقاع
وثانيتها جعل التراب طهورا مع أنه ليس بغسال بل يزيد في تشويه الخلقة
وثالثتها فرض الغسل من المنى والرجيع أنتن منه
ورابعتها نهانا عن إرسال السبع على مثله وأقوى منه ثم أباح إرساله على البهيمة الضعيفة
وخامستها نقص من صلاة المسافر الشطر مما كان عدده أربعا وترك ما كان ركعتين
وسادستها أسقط الصوم والصلاة على الحائض ثم أوجب عليها قضاء الصوم مع أن الصلاة أعظم قدرا من الصوم
وسابعتها جعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصن والمائة من الجوارى الحسان لا يحصن
وثامنتها حرم النظر إلى شعر العجوز الشوهاء مع أنها لا تفتن الرجال الشبان ألبتة وأباح النظر إلى محاسن الأمة الحسناء مع لأنها تفتن الشيخ
وتاسعتها قطع سارق القليل وعفى عن غاصب الكثير
وعاشرتها جلد بالقذف بالزنا ولم يجلد بالقذف بالكفر
وحادية عشرها قبل في الكفر والقتل شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة وهو دونهما
وثانية عشرها جلد قاذف الحر الفاجر وعفا عن قاذف العبد العفيف
وثالثة عشرها أوجب على الصبية المتوفى عنها زوجها العدة وفرق في العدة بين الموت والطلاق مع أن حال الرحم لا يختلف فيهما
ورابعة عشرها جعل استبراء الأمة بحيضة والحرة المطلقة بثلاث حيض
وخامس عشرها يخرج الريح من موضع الغائط وفرض تطهير موضع آخر مع أن غسل ذلك المكان أولى
إذا ثبت هذا فنقول إن مدار القياس على أن الصورتين لما تماثلتا في الحكمة والمصلحة وجب استواؤهما في الحكم
لكن هذه المقدمة لو كانت حقة لامتنع التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات في تلك الصور فلما لم يمتنع ذلك علمنا فساد تلك المقدمة وإذا فسدت تلك المقدمة بطل القول بالقياس
وأما الذين منعوا من القياس في كل الشرائع فقد عرفت أنهم ثلاث فرق
الفرقة الأولى الذين أنكروا كون القياس طريقا إلى الظن وهؤلاء قد تمسكوا بوجوهأحدها أن البراءة الأصلية معلومة والحكم الثابت بالقياس إما أن يكون على وفق البراءة الأصلية أو لا على وفقها فإن كان على وفقها لم يكن في القياس فائدة
وإن كان على خلافها كان ذلك القياس معارضا للبراءة الأصلية لكن البراءة الأصلية دليل قاطع والقياس دليل ظنى والظنى إذا عارض اليقينى كان الظنى باطلا فيلزم كون القياس باطلا
وثانيها أن القياس لا يتم في شيء من المسائل إلا إذا سلمنا أن الأصل في كل شيء بقاؤه على ما كان إذ لو لم يثبت ذلك فهب أن الشارع أمر بالقياس ولكن كيف يعرف أنه بقى ذلك التكليف
وإذا نص على حكم الأصل فكيف يعرف أن ذلك الحكم باق في هذا الزمان فثبت أن القياس لا يتم إلا مع المساعدة على هذا الأصل
إذا ثبت ذلك فنقول الحكم المثبت بالقياس إما أن يكون نفيا أو إثباتا
فإن كان نفيا فلا حاجة فيه إلى القياس لأنا علمنا أن هذا الحكم كان معدوما في الأزل والأصل في كل أمر بقاؤه على ما كان فيحصل لنا ظن ذلك العدم فيكون إثبات ذلك الظن بالقياس مرة أخرى عبثا
فإن قلت ثبوته بدليل لا يمنع من ثبوته بدليل آخر
قلت نعم ولكن بشرط أن لا يفتقر الدليل الثاني إلى الأول
وأما إذا افتقر إلية كان التمسك بالدليل الثاني تطويلا محضا من غير فائدة
وأما إن كان الحكم المثبت بالقياس إثباتا فنقول قد بينا أن قولنا إن الأصل في كل أمر بقاؤه على ما كان يقتضي ظن عدم ذلك الحكم في الحال فلو اقتضى القياس ثبوته في الحال مع أن القياس متفرع على تلك المقدمة لزم وقوع التعارض بين تلك المقدمة التي هى الأصل وبين القياس الذي هو الفرع ولا شك أن في مثل هذا التعارض يجب ترجيح الأصل على الفرع فوجب القطع هاهنا بسقوط القياس
وثالثها أن القياس لا يفيد ظن الحكم إلا إذا ظننا كون الحكم في الأصل معللا بالوصف الفلانى وذلك الظن محال لما سيأتي في الباب الثاني أن تعليل الحكم الشرعي محال
الفرقة الثانية الذين سلموا أن القياس يفيد الظن لكنهم قالوا لا يجوز التكليف بإتباع الظن قالوا لأن الظن قد يخطىء وقد يصيب فالأمر به
أمر بما يجوز أن يكون خطأ وذلك غير جائز
الفرقة الثالثة الذين قالوا يجوز التكليف بإتباع الظن لكنه غير جائز هاهنا قالوا لأن الاكتفاء بالقياس اقتصار على أدون البابين مع القدرة على أعلاهما وذلك غير جائز
إنما قلنا إنه اقتصار على أدون البابين لأنا نعلم بالضرورة أن تنصيص صاحب الشرع أظهر في باب البيان من التفويض إلى القياس
وإنما قلنا إنه مع القدرة على أعلاهما لأنه لا امتناع في التنصيص على أحكام القواعد الكلية
واحترزنا بهذا عن الشهادة والفتوى وقيم المتلفات وأروش الجنايات والتمسك بالأمارات في معرفة القبلة والأمراض والأرباح والأمور الدنيوية لأن هذه الأشياء تختلف بأختلاف الأشخاص والأوقات
والأمكنة والاعتبارات فالتنصيص عليها كالتنصيص على مالا نهاية له وهو محال
وإنما قلنا إن الاقتصار على أدون البابين مع القدرة على أعلاهما غير جائز لأنه إذا لم يقع البيان على أقصى الوجوه حسن من المكلف أن يحمل اليقين على صعوبة البيان لا على تقصير نفسه فالإتيان بكمال البيان إزاحة لعذر المكلف فيكون كاللطف وترك المفسدة في الوجوب
والجواب
أما النقوض فقد ذكرنا أن الدليل الشرعي لما قام على عدم الالتفات إلى تلك المظان لم يبق الظنقوله فحينئذ يصير عدم الدليل المبطل للقياس جزء من المقتضى
قلنا ليس كل ما وجدده يمنع من عمل المقتضى كان عدمه جزء من المقتضي فإن الذي يمنع الثقيل من النزول لا يصير عدمه جزء
المقتضى للنزول لاستحالة كون العدم من العلة الوجودية
قوله جواز الرجوع إلى الظن في الشرعيات مشروط بعدم التمكن من تحصيل العلم
قلنا لا نسلم فإنه إذا حصل الظن الغالب بسبب القياس بأشتمال أحد الطرفين على المفسدة والآخر على المصلحة فإلى أن يستقصى في طلب العلم لابد في الحال من أن يرجح أحد الطرفين على الآخر لامتناع ترك النقيضين وصريح العقل يشهد بأنه لا يجوز ترجيح المرجوح فتعين ترجيح الراجح
وهو الجواب أيضا عن الإمام المعصوم
وأما المعارضات فنقول
أما التمسك بالآيات فالجواب عنها أن الدلالة لما دلت على وجوب العمل بهذا الظن صار كأن الله تعالى قال مهما ظننت أن هذه الصورة تشبه تلك الصورة في علة الحكم فاعلم قطعا أنك مكلف بذلك الحكم
وحينئذ يكون الحكم معلوما لا مظنونا ألبتة
وأما الأحاديث فهي معارضة بالأحاديث الدالة على العمل بالقياس وطريق التوفيق أن نصرف الأمر بالقياس إلى بعض أنواعه والنهي إلى نوع آخر
وأما إجماع الصحابة فقد سبق الجواب عنه
وأما إجماع العترة فممنوع وروايات الإمامية معارضة بروايات الزيدية فانهم
ينقلون عن الأئمة جواز العمل بالقياسقوله العمل بالقياس يستلزم وقوع الاختلاف
قلنا وكذا العمل بالأدلة العقلية والنصوص يستلزم وقوع الخلاف فما هو جوابكم هناك فهو جوابنا هاهنا
قوله لو قال لوكيله اعتق غانما لسواده فإنه لا يعتق عليه كل عبيده السود
قلنا إنه لو صرح بعد ذلك فقال قيسوا عليه سائر عبيدي
لم يعتق عليه سائر عبيده ولو نص الله تعالى على حكم ثم قال قيسوا عليه فلا نزاع في جواز القياس فظهر الفرق بين الصورتين والسبب فيه أن حقوق العباد مبنية على الشح والضنة لكثرة حاجاتهم وسرعة رجوعهم عن دواعيهم وصوار فهم
وأما شبه النظام فجوابها أن غالب أحكام الشرع معلل برعاية المصالح
المعلومة والخصم إنما بين خلاف ذلك في صور قليلة جدا وورود الصور النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في حصول الظن كما أن الغيم الرطب إذا لم يمطر نادرا لا يقدح في ظن نزول المطر منه قوله البراءة الأصلية معلومة والقياس دليل ظنى والظن لا يعارض اليقين
قلنا ينتقض ذلك بجواز العمل بالفتوى والشهادة وتقويم المقومين وبجواز العمل بالظن في الأمور الدنيوية
قوله القياس إما أن يرد على وفق حكم الأصل أو على خلافه
قلنا ينتقض بالأمور المذكورة
قوله الظن قد يخطىء وقد يصيب
قلنا ينتقض بالأمور المذكورة
قوله الاكتفاء بالقياس اكتفاء بأدون البابين مع القدرة على أعلاهما
قلنا إنه كذلك فلم لا يجوز
فإن قالوا لأنه لطف واللطف واجب
قلنا الكلام على هذه الطريقة سبق في باب الإجماع على
الاستقصاء
المسألة الثانية
قال النظام النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياس وهو قول أبي الحسين البصري وجماعة من الفقهاء ومنهم من أنكره وهو المختاروقال أبو عبد الله البصري أن كانت العلة علة في الفعل لم يكن التنصيص عليها تعبدا بالقياس
وأن كانت علة في الترك كان التنصيص عليها تعبدا بالقياس
لنا أن قوله حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل أن تكون العلة هي الإسكار وأن تكون العلة هي إسكار الخمر
بحيث يكون قيد كونه مضافا إلى الخمر معتبرا في العلة وإذا احتمل الأمرين لم يجز القياس إلا عند أمر مستأنف بالقياس
فإن قيل لا نسلم أن قيد كون الإسكار في ذلك المحل يحتمل أن يكون جزء من العلة فإنا لو جوزنا ذلك للزمنا تجويز مثله في العقليات حتى نقول هذه الحركة إنما اقتضت المتحركية لقيامها بهذا المحل فالحركة القائمة لا بهذا المحل لا تكون علة للمتحركية
سلمنا إمكان كونه معتبرا في الجملة لكن العرف يدل على سقوط هذا القيد عن درجة الاعتبار لأن الأب إذا قال لأبنه لا تأكل هذه الحشيشة لأنا سم يقتضى منعه من أكل حشيشة تكون سما
وإذا ثبت ذلك في العرف ثبت مثله في الشرع لقوله عليه الصلاة و السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
سلمنا أنه غير ساقط في العرف إلا أن الأغلب على الظن سقوطه لأن علة الحكم وجب أن تكون منشأ الحكمة ولا مفسدة في كون الإسكار قائما بهذا المحل أو بذاك بل منشأ المفسدة كونه مسكرا فقط فإذا غلب على ظننا ذلك وجب الحكم به احترازا عن الضرر المظنون
سلمنا أن هذا القيد غير ظاهر لكن دليلكم إنما يتمشى فيما إذا قال الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة أما لو قال علة حرمة الخمر إنما هي الإسكار لا يبقى ذلك الاحتمال
سلمنا أن دليلكم يمنع من القياس لكن هاهنا ما يدل على جوازه فإن قول الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة يقتضى إضافة الحرمة إلى الإسكار وذلك يدل على أن العلة هي الإسكار فوجب أن يترتب الحكم عليه أينما وجد
وأما من فرق بين الفعل والترك فقد قال إن من ترك أكل رمانة لحموضتها وجب عليه أن يترك أكل كل رمانة حامضة أما من أكل رمانة لحموضتها لا يجب عليه أن يأكل كل رمانة حامضة
والجواب
قوله هذا الاحتمال قائم في الحركة قلنا إن عنيت بالحركة معنى يقتضى المتحركية فهذا المعنى يمتنع فرضه بدون المتحركية
وإن عنيت بالحركة شيئا آخر بحيث يبقى فيه هذا الاحتمال فهناك نسلم أنه لابد في إبطال ذلك الاحتمال من دليل منفصل
قوله العرف يقتضى إلغاء هذا القيد
قلنا ذاك إنما عرف بالقرينة وهي أن شفقته تمنع من تناول كل ما يقتضى ضررا فلم قلت إن هذا المعنى حاصل في العلة المنصوصة
قوله الغالب على الظن إلغاء هذا القيد
قلنا هب أن الأمر كذلك ولكن إنما يلحق الفرع بالأصل لأنه لما غلب على ظننا كونه في معناه ثم الدليل دل على وجوب الاحتراز من الضرر المظنون فحينئذ يجب علينا أن نحكم في الفرع بمثل حكم الأصل ولكن هذا هو الدليل الذي دل على كون القياس حجة فالتنصيص على علة الحكم لا يقتضى ثبات مثله في الفرع
إلا مع الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس
قوله لو صرح بأن العلة هي الإسكار لا يبقى فيه هذا الاحتمال
قلنا في هذه الصورة نسلم أنه أينما حصل الإسكار حصلت الحرمة لكن ذلك ليس بقياس لأن العلم بأن الإسكار من حيث هو إسكار يقتضى الحرمة يوجب العمل بثبوت هذا الحكم في كل محالة ولم يكن العلم بحكم بعض تلك المحال متأخرا عن العلم بالبعض فلم يكن جعل البعض فرعا والآخر أصلا أولى من العكس فلا يكون هذا قياسا بل إنما يكون قياسا لو قال حرمت الخمر لكونها مسكرة
فحينئذ يكون العلم بثبوت هذا الحكم في الخمر أصلا للحكم به في النبيذ
ومتى قال على هذا الوجه انقدح الاحتمال المذكور
قوله إن قوله حرمت الخمر لكونها مسكرة يقتضى
إضافة الحرمة إلى نفس الأسكار
قلنا لا نسلم فلعل قيد كون الاسكار فيه معتبر في العلية على ما حققناه
قوله من ترك أكل رمانة لحموضتها يجب عليه أن يترك الكل
قلنا لا نسلم لاحتمال أن يكون الداعي له إلى الترك لا مطلق حموضة الرمانة بل حموضة هذه الرمانة وإنها غير حاصلة في سائر الرمانات
سلمناه ولكن لا فرق في ذلك بين الفعل والترك
قوله من أكل رمانة لحموضتها لا يجب عليه أن يأكل كل رمانة حامضة
قلنا ذاك لأنه ما أكلها لمجرد حموضتها بل لأجل حموضتها مع قيام الاشتهاء الصادق لها وخلو المعدة عن الرمان وعلمه بعدم تضرره بها
وهذه القيود بأسرها لم توجد في أكل الرمانة الثانية
المسألة الثالثة
إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون ظاهرا جليا وقد لا يكون كذلكفالأول كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف
ومن الناس من قال المنع من التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوى إلى المنع من أنواع الأذى
لنا وجهان
الأول أن المنع من التأفيف لو دل عليه لدل عليه أما بحسب الموضوع اللغوى أو بحسب الموضوع العرفيوالأول باطل بالضرورة لأن التأفيف غير الضرب فالمنع من التأفيف لا يكون منعا من الضرب
والثاني أيضا باطل لأن النقل العرفي خلاف الأصل
وأيضا فلو ثبت أن النقل في العرف لما حسن من الملك إذا استولى على عدوه أن ينهى الجلاد عن صفعه والاستخفاف به وإن كان يأمره بقتله وإذا بطلت دلالة اللفظ عليه علمنا أن تحريم الضرب مستفاد من القياس
واحتج المخالف بأمور
أحدها لو كان مستفادا من القياس لوجب فيمن لا يقول بصحة القياس أن لا يعلم ذلكوثانيها أنه يلزم أن لا يعلم العاقل حرمة ضربهما لو منعه الله عن القياس الشرعي
وثالثها أجمعنا على أن قوله فلان لا يملك حبة يفيد في العرف أنه لا شيء له ألبتة وكذا قولهم لا يملك نقيرا ولا قطميرا يفيد
أنه ليس له شيء ألبتة وإن كان النقير في أصل اللغة عبارة عن النقرة التي على ظهر النواة والقطمير عبارة عما في شق النواة وكذلك قولهم فلان مؤتمن على قنطار فإنه يفيد في العرف كونه أمينا على الإطلاق
وإنما حكمنا في هذه الألفاظ بالنقل العرفى لتسارع الفهم إلى هذه المعاني العرفية فوجب أن تكون حرمة التأفيف موضوعة في العرف للمنع من الإيذاء لتسارع الفهم إليه
والجواب عن الأول
أن القياس قد يكون يقينيا وقد يكون ظنياأما الأول فكمن علم علة الحكم في الأصل ثم علم حصول مثل تلك العلة في الفرع فإنه لابد وأن يعلم ثبوت الحكم في الفرع
أما الثاني فكما إذا كانت إحدى المقدمتين أو كلاهما مظنونة والقياس في هذه المسألة من النوع الأول فلا جرم لا يمكن أن
يكون القادح في صحة القياس الظنى قادحا في صحة هذا القياس
وهذا هو الجواب بعينه عن الثاني
أما الثالث فقوله ليس لفلان حبة يفيد نفى الأكثر من الحبة لأن الأكثر من الحبة يوجد فيه الحبة أما ما نقص من الحبة فلا يتعرض له كلامهوأما النقير والقطمير فقد حكمنا فيه بالنقل العرفي للضرورة ولا ضرورة في مسألتنا
وأما قوله فلان مؤتمن على قنطار فأنما يفيد كونه مؤتمنا على ما دون القنطار لأن ما دون القنطار داخل في القنطار فأما ما فوقه فلا يدخل فيه
المسألة الرابعة
ثبوت الحكم في الأصل إما أن يكون يقينيا أو لا يكون فإن كان يقينيا استحال أن يكون ثبوت الحكم في الفرع أقوى منه لأنه ليس فوق اليقين درجة
أما إذا لم يكن يقينيا فثبوت الحكم في الفرع أما أن يكون أقوى من ثبوته في الأصل أو مساويا له أو دونه
مثال الأول قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف فإن تحريم الضرب وهو الفرع أقوى ثبوتا من تحريم التأفيف الذي هو الأصل
ومثال الثاني قوله عليه الصلاة و السلام لا يبولن أحدكم في الماء الراكد فأنا نقيس عليه ما إذا بال في الكوز ثم صبه في الماء الراكد ولا تفاوت بين الحكم في الأصل والفرع وهذا هو الذي يسمى بالقياس في معنى الأصل
ومثال الثالث جميع الأقيسة التي يتمسك الفقهاء بها في مباحثهم
وأما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب الظنون ولما كانت مراتب الظنون محصورة فكذا القول في مراتب هذا التفاوت
القسم الثاني
في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل قد عرفت أن حاصل القياس يرجع إلى أصلينأحدهما
أن الحكم في محل النص معلل بالوصف الفلاني
وثانيهما
أن ذلك الوصف حاصل في الفرع
والأصل الأول أعظمهما وأولاهما بالبحث والتدقيق
والكلام في هذا القسم مرتب على مقدمة وأربعة أبواب
أما المقدمة ففي تفسير العلة
في هذا الموضع قال نفاة القياس إما أن يكون المراد من العلة ما يكون مؤثرا في الحكم أو ما يكون داعيا للشرع إلى إثباته أو ما يكون معرفا له أو معنى رابعاوالثلاثة الأولة باطلة
والرابع لابد من إفادة تصوره لننظر فيه هل يصح أم لا
أما الأول وهو الموجب فهو باطل من وجوه
أحدها أن حكم الله تعالى على قول أهل السنة مجرد خطابه الذي هو كلامه القديم والقديم يمتنع تعليله فضلا على أن يعلل بعلة محدثة
وأما على قول من يقول الأحكام أمور عارضة للأفعال معللة بوقوع تلك الأفعال على جهات مخصوصة فهو قول المعتزلة في الحسن والقبح العقليين وقد أبطلتموه
وثانيها أن الواجب هو الذي يستحق العقاب على تركه واستحقاق العقاب وصف ثبوتي لأنه مناقض لعدم الاستحقاق وتركه هو أن لا يفعله وهو عدمى ولو كان ذلك الاستحقاق معللا بهذا الترك لكان الوجود معللا بالعدم وهو محال
فإن قلت لم لا يجوز أن يقال القادر لا ينفك عن فعل الشيء أو فعل ضده فإذا ترك الواجب فقد فعل ضده واستحقاق العقاب معلل بفعل ضده
قلت هذا لا يستقيم على رأى أبي هاشم وأبي الحسين وأتباعهما لأنه يجوز عندهما خلو القادر من الأخذ والترك
وأيضا ففعل الضد لو لم يستلزم الإخلال بواجب لم يستلزم استحقاق الذم والعقاب ولو فرضنا وقوع الإخلال بالواجب من غير
فعل الضد لاستلزم استحقاق الذم والعقاب فعلمنا أن المستلزم بالذات لهذا الاستحقاق هو أن لا يفعل الواجب لا فعل ضده
وثالثها أن العلة الشرعية لو كانت مؤثرة في الحكم لما اجتمع على الحكم الواحد علل مستقلة لكن قد يحصل هذا الإجماع فالعلة غير مؤثرة
بيان الملازمة أن الحكم مع علته المستقلة واجب الحصول وما كان واجب الحصول لذاته استحال وقوعه لأن الواجب لذاته لا يكون واجبا لغيره فإذا اجتمعت عليه علل مستقلة كان لكونه مع هذا منقطعا عن الآخر وبالعكس فيلزم استغناؤه عن الكل حال احتياجه إلى الكل وهو محال
بيان استثناء نقيض التالي ما إذا زنا وأرتد أو لمس ومس معا فإن الحكم هاهنا واحد لامتناع اجتماع المثلين
وبتقدير جوازه فإنه لا يكون استناد أحد الحكمين إلى أحد العلتين أولى من استناده إلى العلة الأخرى ومن استناد الحكم الأخر
إليها فيعود إلى كون كل واحد من الحكمين معللا بكل واحدة من العلتين وهو محال
ورابعها أن كون القتل العمد العدوان قبيحا وموجبا لأستحقاق الذم والقصاص لو كان معللا بكونه قتلا عمدا عدوانا والعدوانية صفة عدمية لأن معناها انها غير مستحقة لزم أن يكون العدم جزء من علة الأمر الوجودي وهو محال
فإن قلت لم لا يجوز أن يكون هذا العدم شرطا لصدور الأثر عن المؤثر
قلت لأن عليه العلة ما كانت حاصلة قبل حصول هذا الشرط ثم حدثت عند حصوله فتلك العلية أمر حادث لابد له من مؤثر وهو الشرط فلو جعلنا الشرط عدما لزم جعل العدم علة لتلك العلية وهو محال
ومن الفقهاء من قال هذه الإشكالات إنما تتوجه على من يجعل هذه الأوصاف عللا مؤثرة لذواتها في هذه الأحكام ونحن لا نقول بذلك بل كونها عللا لهذه الأحكام أمر ثبت بالشرع فهي لا توجب الأحكام لذواتها بل لأن الشرع جعلها موجبة لهذه الأحكام
وهذا هو الذي عول عليه الغزالى في شفاء الغليل فيقال له إن أردت بجعل الزنا علة موجبة للرجم أن الشرع قال مهما رأيتم إنسانا يزني فاعلموا أني أوجبت رجمه فهذا صحيح ولكن يرجع حاصله إلى كون الزنا معرفا لذلك الحكم وهو غير ما نحن الآن فيه
وإن أردت به أن الشرع جعل الزنا مؤثرا في هذا الحكم فهو باطل من وجهين
الأول أنه معترف بأن الحكم ليس إلا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وذلك هو كلامه القديم فكيف يعقل كون الصفة المحدثة موجبة للشيء القديم سواء كانت الموجبية بالذات أو بالجعل
الثاني أن الشارع إذا جعل الزنا علة فحال ذلك الجعل إن لم يصدر
عنه أمر ألبتة لم يكن جاعلا ألبتة
وإن صدر عنه أمر فذلك الأمر إما الحكم أو ما يؤثر في الحكم أو لا الحكم ولا ما يؤثر في الحكم
فإن كان الصادر هو الحكم كان المؤثر في الحكم هو الشارع لا الوصف وقد فرض أن المؤثر هو الوصف هذا خلف
وإن كان الصادر ما يؤثر في الحكم كان تأثير الشارع في إخراج ذلك المؤثر من العدم إلى الوجود ثم إنه بعد وجوده يؤثر في الحكم لذاته فتكون موجبيتة لذاته لا بالشرع
وإن كان الصادر لا الحكم ولا ما يؤثر فيه ألبتة لم يحصل الحكم حينئذ وإذا لم يحصل الحكم لم يجعل الشرع ذلك الوصف موجبا لذلك الحكم وقد فرض كذلك هذا خلف
التفسير الثاني
الداعى وهو بالحقيقة أيضا موجب لأن القادر لما صح
منه فعل الشيء وفعل ضده لم تترجح فاعليته للشيء على فاعليته لضده إلا إذا علم أن له فيه مصلحة فذلك العلم هو الذي لأجله صار القادر فاعلا لهذا الضد بدلا من كونه فاعلا لذلك الضد لكن العلم موجب لتلك الفاعلية ومؤثر فيها فمن قال أكلت للشبع كان معناه ذلك
إذا عرفت هذا فنقول هذا في حق الله تعالى محال لوجهين
الأول أن كل من فعل فعلا لغرض فإنه مستكمل بذلك الغرض والمستكمل بغيره ناقص بذاته وذلك على الله تعالى محال
وإنما قلنا إن فعل فعلا لغرض فإنه مستكمل بذلك الغرض لأنه إما أن يكون حصول ذلك الغرض ولا حصوله بالنسبة إليه
في اعتقاده على السواء وإما أن يكون أحدهما أولى به في اعتقاده
فإن كان الأول استحال أن يكون غرضا والعلم به ضرورى بعد الاستقراء والاختبار
وإن كان الثاني كان حصول تلك الأولوية معلقا بفعل ذلك الغرض وكل ما كان معلقا على غيره لم يكن واجبا لذاته فحصول ذلك الكمال غير واجب لذاته فهو ممكن العدم لذاته فلا يكون كمال الله تعالى صفة واجبة له بل ممكنة الزوال عنه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
فإن قلت حصول ذلك الغرض ولا حصوله بالنسبة إليه تعالى على السواء ولكن بالنسبة إلى غيره لا على السواء فلا جرم أن الله تعالى يفعل لا لغرض يعود إليه بل الغرض يعود إلى عبده
قلت كونه تعالى فاعلا للفعل الذي هو أولى بالعبد وكونه غير فاعل له إما أن يتساويا بالنسبة إليه تعالى من جميع الوجوه أو لا يتساويا
فإن كان الأول استحال أن يكون ذلك داعيا لله تعالى إلى الفعل
وأيضا
فكيف يعقل هذا مع أن المعتزلى يقول لو لم يفعل لاستحق الذم ولما كان مستحقا للمدح ولصار سفيها غير مستحق للآلهية وأن كان أحدهما أولى عاد الإشكال
الثاني
أن البديهة شاهدة بأن الغرض والحكمة ليس إلا جلب المنفعة أو دفع المضرة والم عبارة عن اللذة أو ما يكون وسيلة إليها
والمضرة عبارة عن الألم أو ما يكون وسيلة إليه والوسيلة
إلى اللذة مطلوبة بالعرض والمطلوب بالذات هو اللذة
وكذا الوسيلة إلى الألم مهروب عنها بالغرض والمهروب عنه بالذات ليس إلا الألم فيرجع حاصل الغرض والحكمة إلى تحصيل اللذة ورفع الألم ولا لذة إلا والله تعالى قادر على تحصيلها إبتداء من غير شيء من الوسائط ولا ألم إلا والله تعالى قادر على دفعه ابتداءا من غير شيء من الوسائط وإذا كان الأمر كذلك استحال أن تكون فاعليته لشيء لأجل تحصيل اللذة أو دفع الألم لأن الشيء إنما يكون معللا بشيء آخر إذا كان يلزم من عدم ما فرض علة وعدم كل ما يقوم مقامها أن لا تكون العلية حاصلة ألبتة
وبهذا الطريق علمنا أن نعيق الغراب وصرير الباب ليس علة لوجود السماء والأرض ولا بالعكس
وإذا ثبت هذا فنقول لما لم تكن فاعلية الله تعالى لتحصيل اللذات ودفع الآلام متوقفا ألبتة على وجود هذه
الوسائط ولم تكن أيضا فاعليته للوسائط متوقفة على فاعليته لتلك اللذات والآلام استحال تعليل أحدهما بالآخر
وإذا بطل التعليل بطل كونها داعية لما بينا أن الداعى علة لعلية الفاعلية
التفسير الثالث للعلة المعرف فنقول إنه أيضا باطل لأنا إذا قلنا الحكم في الأصل معلل بالعلة الفلانية استحال أن يكون مرادنا من العلة المعرف وإلا لكان معنى الكلام أن الحكم في الأصل إنما عرف ثبوته بواسطة الوصف الفلاني وذلك باطل لأن علية الوصف لذلك الحكم لا تعرف إلا بعد معرفة ذلك الحكم فكيف يكون الوصف معرفا
والجواب
أما المعتزلة فإنهم يفسرون العلة الشرعية تارة بالموجب وتارة بالداعى فيحتاجون إلى الجواب عن هذه الكلمات التي سبقت والكلام في ذلك طويل
وأما أصحابنا فإنهم يفسرونه بالمعرف
وأما قوله الحكم معرف بالنص فلا يمكن كون الوصف معرفا له
قلنا ذلك الحكم الثابت في محل الوفاق فرد من أفراد ذلك النوع من الحكم ثم بعد ذلك يجوز قيام الدلالة على كون ذلك الوصف معرفا لفرد أخر من أفراد ذلك النوع من الحكم وعلى ذلك التقدير لا يكون تعريفا للمعرف
ثم إذا وجدنا ذلك الوصف في الفرع حكمنا بحصول ذلك الحكم لما أن الدليل لا ينفك عن المدلول
الباب الأول
في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل وهي عشرة النص والإيماء والإجماع والمناسبة والتأثير والشبه والدوران والسبر والتقسيم والطرد وتنقيح المناط وأمور أخرى اعتبرها قوم وهي عندنا ضعيفة
الفصل الأول في النص
ونعنى بالنص ما تكون دلالته على العلية ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملةأما القاطع فما يكون صريحا في المؤثرية وهو قولنا لعله كذا أو لسبب كذا أو لموجب كذا أو لأجل كذا كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل
وأما الذي لا يكون قاطعا فألفاظ ثلاثة اللام وإن والباء
أما اللام فكقولنا ثبت لكذا كقوله
وما خلقت الجن الأنس إلا ليعبدون
فإن قلت اللام ليست صريحة في العلية ويدل عليه وجوه
الأول أنها تدخل على العلة فيقال ثبت هذا الحكم لعلة كذا ولو كانت اللام صريحة في التعليل لكان ذلك تكرارا
الثاني أنه تعالى قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وبالاتفاق لا يجوز أن يكون ذلك غرضا
الثالث قول الشاعر ... لدوا للموت وابنوا للخراب
وليست اللام هاهنا للغرض
الرابع يقال أصلى لله تعالى ولا يجوز أن تكون ذات الله تعالى غرضا
قلت أهل اللغة صرحوا بأن اللام للتعليل وقولهم حجة
وإذا ثبت ذلك وجب القول بأنها مجاز في هذه الصور
وثانيها أن كقوله عليه الصلاة و السلام إنها من الطوافين عليكم إنه دم عرق
وثالثها الباء كقوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
واعلم أن أصل الباء للإلصاق وذات العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل معنى الإلصاق هناك فحسن إستعمال الباء فيه مجازا
الفصل الثاني في الإيماء وهو على خمسة أنواع
الأول تعليق الحكم على العلة بحرف الفاء وهو على وجهينالأول أن تدخل الفاء على حرف العلة ويكون الحكم متقدما كقوله عليه الصلاة و السلام في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا
الثاني أن تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك أيضا على وجهين
أحدهما أن تكون الفاء دخلت في كلام الشارع مثل قوله تعالى
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وثانيها أن تدخل على رواية الراوى كقول الراوى سها رسول الله صلى الله عليه و سلم فسجد وزنا ماعز فرجم
فرعان
الأول الحكم المرتب على الوصف مشعر بكون الوصف علة سواء كان ذلك الوصف مناسبا لذلك الحكم أو لم يكن مناسبا لذلك الحكموقال قوم لا يدل على العلية إلا إذا كان مناسبا
لنا وجهان
الأول أن الرجل إذا قال أكرموا الجهال واستخفوا بالعلماء يستقبح هذا الكلام في العرف فلا يخلو إما أن يكون الاستتباح جاء لأنه فهم منه أنه حكم يكون الجاهل مستحقا للإكرام بجهله ويكون العالم مستحقا للاستخفاف بعلمه أو لأنه فهم منه أنه جعل الجاهل مستحقا للإكرام والعالم مستحقا للاستخفاف
والثاني باطل لأن الجاهل قد يستحق الإكرام بجهة أخرى نحو نسبه أو شجاعته أو سوابق حقوقه والعالم قد يستحق الاستخفاف لفسقه أو لسبب آخر
وإذا بطل هذا القسم ثبت الأول وذلك يدل على أن ترتيب الحكم على الوصف يفيد كون الوصف علة الحكم سواء تحققت المناسبة أو لم تتحقق
فإن قلت لم لا يجوز أن يقال إن الاستقباح إنما جاء لأن الجهل مانع من الإكرام والعلم مانع من الاستخفاف فلما أمر بإكرام الجاهل فقد أثبت الحكم مع قيام المانع
وأيضا فهب أن الحكم في هذا المثال كذلك فلم قلت إنه في سائر الصور يجب أن يكون كذلك
قلت الجواب عن الأول
أنا قد بينا أنه قد يثبت استحقاق الإكرام مع الجهل فوجب أن لا يكون الجهل مانعا منه لئلا يلزم مخالفة الأصلوعن الثاني أنه لما ثبت ما ذكرناه في بعض الصور وجب ثبوته في كل الصور وإلا وقع الاشتراك في هذا النوع من التركيب والاشتراك على خلاف الأصل
الوجه الثاني في المسألة أنه لا بد لهذا الحكم من علة ولا علة إلا هذا الوصف
أما الأول فلأنه لو ثبت الحكم بدون العلة والداعى كان عبثا وهو على الله تعالى محال
وأما الثاني فلأن غير هذا الوصف كان معدوما والعلم بأنه كان معدوما يوجب ظن بقائه على ذلك على ما سيأتى
تقرير هذا الأصل وإذا بقي على العدم امتنع أن يكون علة
فثبت أن غيره يمتنع أن يكون علة فوجب أن تكون العلة ذلك الوصف
الفرع الثاني
قد ذكرنا أن دخول الفاء يقع على ثلاثة أوجه ولا شك أن قول الشارع أبلغ في إفادة العلية من قول الراوى لأنه يجوز أن يتطرق إلى كلام الراوى من الخلل ما لا يجوز تطرقه إلى كلام الشارعوأما القسمان الباقيان فيشبه أن يكون الذي تقوم العلة فيه على الحكم أقوى في الأشعار بالعلية من القسم الثاني لأن أشعار العلة بالمعلول أقوى من أشعار المعلول بالعلة لأن الطرد واجب في العلل والعكس غير واجب فيها
النوع الثاني أن يشرع الشارع الحكم عند علمه بصفة المحكوم عليه فيعلم
أنها علة الحكم فإذا قال القائل يا رسول الله أفطرت فيقول عليك الكفارة فيعلم أن الكفارة وجبت لأجل الإفطار
وإنما قلنا إن ذلك مشعر بالعلية لأن قوله عليك الكفارة كلام يصلح أن يكون جوابا عن ذلك سؤال والكلام الذي يصلح أن يكون جوابا عن السؤال إذا ذكر عقب السؤال يفيد الظن بأنه إنما ذكره جوابا عن السؤال وإذا ذكره جوابا عن السؤال كان السؤال كالمعاد في الجواب فيصير التقدير أفطرت فأعتق
وحينئذ يلتحق هذا بالنوع الأول
فإن قلت لا نزاع في أن هذا الكلام صالح لأن يكون جوابا عن ذلك السؤال لكن لا نسلم أن مثل هذا الكلام إذا ذكر عقيب
السؤال حصل ظن أنه ذكر ليكون جوابا عن ذلك السؤال فإنه ربما ذكره جوابا عن سؤال آخر أو لغرض آخر أو زجرا له عن هذا السؤال كما أن العبد إذا قال لسيده دخل فلان دارك فيقول له السيد اشتغل بشأنك فمالك وهذا الفضول ولا يمكن إبطال هذا الاحتمال بما قاله بعضهم من أنه لو لم يكن هذا الكلام جوابا عن ذلك السؤال لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وإنه لا يجوز لاحتمال أنه عليه الصلاة و السلام عرف أنه لا حاجة بذلك المكلف إلى ذلك الجواب في ذلك الوقت فلا يكون اعراض الرسول صلى الله عليه و سلم عن ذكر الجواب تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة
سلمنا أن ما يقوله الرسول صلى الله عليه و سلم جوابا عن السؤال مشعر بالتعليل فلم قلتم إن الذي يزعم الراوى أنه جواب عن السؤال مشعر به لاحتمال أنه اشتبه الأمر على الراوى فظن ما لم يكون جوابا جوابا
قلت الجواب عن الأول
أن الأكثر على أن الكلام الذي يصلح أن يكون جوابا عن السؤال إذا ذكر عقيب السؤال فإنما يذكر جوابا عنه والصورة التي ذكرتموها نادرة والنادر مرجوحوعن الثاني أن العلم يكون الكلام المذكور بعد السؤال جوابا عنه أو ليس جوابا عنه أمر ظاهر يعرف بالضرورة عند مشاهدة المتكلم ولا يفتقر فيه إلى نظر دقيق
النوع الثالث أن يذكر الشارع في الحكم وصفا لو لم يكن موجبا لذلك الحكم لم يكن في ذكره فائدة
وهذا يقع على أقسام أربعة
أحدها أن يدفع السؤال المذكور في صورة الإشكال بذكر الوصف كما روى أنه عليه الصلاة و السلام امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل له إنك تدخل على فلان وعنده هرة فقال عليه الصلاة و السلام إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات فلو لم يكن لكونها من الطوافين أثر في طهارتها لم يكن لذكره عقيب الحكم بطهارتها فائدة
وثانيها أن يذكر وصفا في محل الحكم لا حاجة إلى ذكره إبتداء فيعلم أنه إنما ذكره لكونه مؤثر في الحكم كما روى أنه عليه الصلاة و السلام قال تمرة طيبة وماء طهور
وثالثها أن يقرر النبي صلى الله عليه و سلم على وصف الشيء المسئول عنه كقوله صلى الله عليه و سلم أينقص الرطب إذا جف قالوا نعم قال فلا إذن فلو لم يكن نقصانه
باليبس علة في المنع من البيع لم يكن للتقرير عليه فائدة
وهذا أيضا يدل على العلية من حيث الجواب بالفاء
ورابعها أن يقرر الرسول صلى الله عليه و سلم على حكم ما يشبه المسئول عنه وينبه على وجه الشبه فيعلم أن وجه الشبه هو العلة في ذلك الحكم كقوله عليه الصلاة و السلام لعمر رضى الله عنه وقد سأله عن قبلة الصائم أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته فنبه بهذا على أنه لا يفسد الصوم بالمضمضة والقبلة
لأنه لم يحصل ما هو الأثر المطلوب منهما
النوع الرابع أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فيعلم أنه لو لم تكن تلك الصفة علة لم يكن لذكرها فائدة
وهو ضربان
أحدهما أن لا يكون حكم أحدهما مذكورا في الخطاب كقوله عليه الصلاة و السلام القاتل لا يرث فإنه قد تقدم بيان إرث الورثة فلما قال القاتل لا يرث وفرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز كونه مؤثرا في نفي الإرث علمنا أنه العلة في نفي الإرثوثانيها أن يكون حكمهما مذكورا على الخطاب
وهو على خمسة وجوه
أحدها أن تقع التفرقة بلفظ يجرى مجرى الشرط كقوله عليه الصلاة و السلام فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد بعد نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلا فدل على أن اختلاف الجنسين علة في جواز البيعوثانيها أن تقع التفرقة في الغاية كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن
وثالثها أن تقع بالاستثناء كقوله تعالى إلا أن يعفون
ورابعها أن تقع بلفظ يجرى مجرى الاستدراك كقوله تعالى لا يؤاخذكم الله
باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فدل على أن التعقيد مؤثر في المؤاخذة
وخامسها أن يستأنف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الأخرى وتكون تلك الصفة مما يجوز أن يؤثر كقوله صلى الله عليه و سلم للراجل سهم وللفارس سهمان وأعلم أن الاعتماد على هذين النوعين على أنه لا بد لتلك التفرقة من سبب ولا بد في ذكر ذلك الوصف من فائدة فإذا جعلنا الوصف سببا للتفرقة حصلت الفائدة
النوع الخامس
النهى عن فعل يمنع ما تقدم وجوبه علينا فيعلم أن العلة في ذلك النهي كونه مانعا من ذلك الواجب كقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإنه لما أوجب علينا السعي ونهانا عن البيع مع علمنا بأنه لو لم يكن النهي عن البيع لكونه مانعا من السعى لكان ذكره في هذا الموضع غير جائز وذلك يدل على أنه إنما نهانا عنه لأنه يمنع من الواجب
وكتحريم التأفيف فإن العلة فيه كونه مانعا من الإعظام الواجب فهذه جملة أقسام الإيماءات
مسألة
الظاهر من هذه الأقسام وإن دل على العلية لكن قد يترك هذا الظاهر عند قيام الدليل عليه مثاله قوله عليه الصلاة و السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان ظاهره يدل على أن العلة هي الغضب ولكن لما علمنا أن الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر لا يمنع من القضاء وأن الجوع المبرح والألم المبرح يمنع علمنا أن علة المنع لست هي الغضب بل تشويش الفكر
قوله من يقول الغضب هو العلة لكن لكونه مشوشا خطأ لأن الحكم لما دار مع تشويش الفكر وجودا وعدما وانقطع عن الغضب وجودا وعدما وليس بين التشويش والغضب ملازمة أصلا لأن تشويش الفكر قد يوجد حيث لا غضب والغضب يوجد حيث لا تشويش علمنا أنه ليس بينهما ملازمة
وحينئذ تعلم أنه لا يمكن أن يكون الغضب علة بل العلة إنما هو التشويش فقط إلا أنه يجوز إطلاق لفظ الغضب لإرادة التشويش إطلاقا لاسم السبب على المسبب
ويجب أن يعلم أن الذي به يصرف اللفظ عن ظاهرة لابد وأن يكون أقوى وجهات القوة ستأتي في باب الترجيح إن شاء الله تعالى
الفصل الثالث في بيان علية الوصف بالمناسبة وهو مرتب على فنين
الأول في المقدمات وفيه مسائلالمسألة الأولى في تعريف المناسبة الناس ذكروا في تعريف المناسب شيئين
الأول أنه الذي يفضى إلى ما يوافق الإنسان تحصيلا وإبقاء وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة وعن الإبقاء بدفع المضرة لأن ما قصد إبقاؤه فإزالته مضرة وإبقاؤه دفع المضرة
ثم هذا التحصيل والإبقاء قد يكون معلوما وقد يكون مظنونا وعلى التقديرين فإما أن يكون دينيا أو دنيويا
والمنفعة عبارة عن اللذة أو ما يكون طريقا إليها
والمضرة عبارة عن الألم أو ما يكون طريقا إليه
واللذة قيل في حدها إنها إدراك الملائم
والألم إدراك المنافي
والصواب عندي أنه لا يجوز تحديدهما لأنهما من أظهر ما يجده الحي من نفسه ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحد منهما وبينهما وبين غيرهما وما كان كذلك يتعذر تعريفه بما هو أظهر منه
الثاني أنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات فإنه يقال هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة أي الجمع بينهما في سلك واحد متلائم وهذه الجبة تناسب هذه العمامة أي الجمع بينهم متلائم
والتعريف الأول قول من يعلل أحكام الله تعالى بالحكم والمصالح والتعريف الثاني قول من يأباه
المسألة الثانية
في تقسم المناسب وذلك من أوجه
التقسيم الأول المناسب إما أن يكون حقيقيا أو إقناعيا أما الحقيقي فنقول كون المناسب مناسبا إما أن يكون لمصلحة تتعلق بالدنيا أو لمصلحة تتعلق بالآخرة
أما القسم الأول فهو على ثلاثة أقسام لأن رعاية تلك المصلحة أما أن تكون في محل الضرورة أو في محل الحاجة أو لا في محل الضرورة ولا في محل الحاجة
أما التي في محل الضرورة فهي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهى حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل
أما النفس فهي محفوظة بشرع القصاص وقد
نبه الله تعالى عليه بقوله ولكم في القصاص حياة
وأما المال فهو محفوظ بشرع الضمانات والحدود
وأما النسب فهو محفوظ بشرع الزواجر عن الزنا لأن المزاحمة على الأبضاع تفضي إلى اختلاط الأنساب المفضى إلى انقطاع التعهد عن الأولاد وفيه التوثب على الفروج بالتعدي والتغلب وهو مجلبة الفساد والتقاتل
وأما الدين فهو محفوظ بشرع الزواجر عن الردة والمقاتلة مع أهل الحرب وقد نبه الله تعالى عليه بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
وأما العقل فهو محفوظ بتحريم المسكر وقد نبه الله تعالى عليه بقوله أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر
فهذه الخمسة هي المصالح الضرورية
وأما التي في محل الحاجة فتمكين الولى من تزويج الصغيرة فإن مصالح النكاح غير ضرورية لها في الحال إلا أن الحاجة إليه بوجه ما حاصلة وهي تقييد الكفؤ الذي لو فات فربما فات لا إلى بدل
وأما التي لا تكون في محل الضرورة ولا الحاجة فهي التي تجري مجرى التحسينات وهي تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم
وهذا على قسمين
منه ما يقع لا على معارضة قاعدة معتبرة وذلك كتحريم تناول القاذورات وسلب أهلية الشهادة عن الرقيق لأجل أنها منصب شريف والرقيق نازل القدر والجمع بينهما غير متلائمومنه ما يقع على معارضة قاعدة معتبرة وهو مثل الكتابة فإنها وإن كانت مستحسنة في العادات إلا أنها في الحقيقة بيع الرجل ماله بماله وذلك غير معقول
وأما الذي يكون مناسبا لمصلحة تتعلق بالآخرة فهي الحكم المذكورة في رياضة النفس وتهذيب الأخلاق فإن منفعتها في سعادة الآخرة
فرع
أن كل واحدة من هذه المراتب قد يقع فيه ما يظهر كونه من ذلك القسموقد يقع فيه ما لا يظهر كونه منه بل يختلف ذلك بحسب اختلاف الظنون
وقد استقصى إمام الحرمين رحمه الله في أمثله هذه الأقسام
ونحن نكتفى بواحد منها قال رحمه الله قد ذكرنا أن حفظ النفوس بشرع القصاص من باب المناسب الضروري
ومما نعلم قطعا أنه من هذا الباب شرع القصاص في المثقل فإنا كما نعلم أنه لو لا شرع القصاص في الجملة لوقع الهرج والمرج
فكذلك نعلم أنه لو ترك في المثقل لوقع الهرج ولأدى الأمر إلى أن كل من أراد قتل إنسان فإنه يعدل عن المحدد إلى المثقل دفعا للقصاص عن نفسه إذ ليس في المثقل زيادة مؤنة ليست في المحدد بل كان المثقل أسهل من المحدد وعند هذا قال رحمه الله لا يجوز في كل شرع تراعى فيه مصالح الخلق عدم وجوب القصاص بالمثقل
قال رحمه الله فأما إيجاب قطع الأيدي باليد الواحدة فإنه يحتمل أن يكون من هذا الباب لكنه لا يظهر كونه منه
أما وجه الاحتمال فلأنا لو لم نوجب قطع الأيدي باليد الواحدة لتأدى الأمر إلى أن كل من أراد قطع يد إنسان استعان بشريك ليدفع القصاص عنه فتبطل الحكمة المرعية بشرع القصاص
وأما أنه لا يظهر كونه من هذا الباب فلأنه يحتاج فيه إلى الاستعانة بالغير وقد لا يساعده الغير عليه فليس وجه الحاجة إلى شرع القصاص من هاهنا مثل وجه الحاجة إلى شرعه في المنفرد
وأما المناسب الإقناعى فهو الذي يظن به في أول الأمر كونه مناسبا لكنه إذا بحث عنه حق البحث يظهر أنه غير مناسب مثاله تعليل الشافعية تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة بنجاستها وقياس الكلب والسرجين عليه
ووجه المناسبة أن كونه نجسا يناسب إذلاله ومقابلته بالمال في البيع يناسب إعزازه والجمع بينهما متناقض
وهذا وإن كان يظن به في الظاهر أنه مناسب لكنه في الحقيقة ليس كذلك لأن كونه نجسا معناه أنه لا يجوز
الصلاة معه ولا مناسبة ألبتة بين المنع من استصحابه في الصلاة وبين المنع من بيعه
التقسيم الثاني
الوصف المناسب إما أن يعلم أن الشارع اعتبره أو يعلم أنه ألغاه أو لا يعلم واحد منهماأما القسم الأول فهو على أقسام أربعة لأنه إما أن يكون نوعه معتبرا في نوع ذلك الحكم أو في جنسه أو يكون جنسه معتبرا في نوع ذلك الحكم أو في جنسه
مثال تأثير النوع في النوع أنه إذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضت حقيقة التحريم كان النبيذ ملحقا بالخمر لأنه لا تفاوت بين العلتين وبين الحكمين إلا اختلاف المحلين واختلاف المحل لا يقتضي ظاهرا اختلاف الحالين
مثال تأثير النوع في الجنس أن الإخوة من الأب والأم نوع واحد يقتضى التقدم في الميراث فيقاس عليه التقدم في
النكاح والأخوة من الأب والأم نوع واحد في الموضعين إلا أن ولاية النكاح ليست كولاية الإرث لكن بينهما مجانسة في الحقيقة
ولا شك أن هذا القسم دون القسم الأول في الظهور لأن المفارقة بين المثلين بحسب اختلاف المحلين أقل من المفارقة بين نوعين مختلفين
مثال تأثير الجنس في النوع إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض تعليلا بالمشقة فإنه ظهر تأثير جنس المشقة في إسقاط قضاء الصلاة وذلك مثل تأثير المشقة في السفر في إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين
مثال تأثير الجنس في الجنس تعليل الأحكام بالحكم التي لا تشهد لها أصول معينة مثل أن عليا رضى الله عنه أقام الشرب مقام القذف إقامة لمظنة الشيء مقامه قياسا على إفامة
الخلوة بالمرأة مقام وطئها في الحرمة
ثم أعلم أن للجنسية مراتب فأعم أوصاف الأحكام كونها حكما ثم ينقسم الحكم إلى تحريم وإيجاب وندب وكراهة
والواجب ينقسم إلى عبادة وغيرها
والعبادة تنقسم إلى الصلاة وغيرها
والصلاة تنقسم إلى فرض ونقل
فما ظهر تأثيره في الفرض أخص مما ظهر تأثيره في الصلاة
وما ظهر تأثيره في الصلاة أخص مما ظهر تأثيره في العبادة
وكذا في جانب الوصف أعم أوصافه كونه وصفا تناط به الأحكام حتى تدخل فيه الأوصاف المناسبة وغير المناسبة
وأخص منه المناسب
وأخص منه المناسب الضروري
وأخص منه ما هو كذلك في حفظ النفوس
وبالجملة فالأوصاف إنما يلتفت إليها إذا ظن التفات الشرع إليها وكل ما كان التفات الشرع إليه أكثر كان ظن كونه معتبرا أقوى
وكلما كان الوصف والحكم أخص كان ظن كون ذلك الوصف معتبرا في حق ذلك الحكم آكد فيكون لا محالة مقدما على ما يكون اعم منه
وأما المناسب الذي علم أن الشرع ألغاه فهو غير معتبر أصلا
وأما المناسب الذي لا يعلم أن الشرع ألغاه أو اعتبره فذلك يكون بحسب أوصاف أخص من كونه وصفا مصلحيا وإلا فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له بالاعتبار وهذا القسم هو المسمى بالمصالح المرسلة
واعلم أن كل واحد من هذه الأقسام الأربعة مع كثرة مراتب العموم والخصوص قد يقع فيه كل واحد من الأقسام الخمسة المذكورة في التقسيم الأول ويحصل هناك أقسام كثيرة جدا وتقع فيما بينها المعارضات والترجيحات ولا يمكن ضبط القول فيها لكثرتها والله تعالى هو العالم بحقائقها
التقسيم الثالث
الوصف بأعتبار الملاءمة ووقوع الحكم على وفق أحكام أخر وشهادة الأصل على أربعة أقسامالأول
ملائم شهد له أصل معين وهو الذي أثر نوع الوصف في نوع الحكم وأثر جنسه في جنسه وهذا متفق على قبوله بين القايسين وهو كقياس المثقل على الجارح في وجوب القصاص فخصوص كونه قتلا معتبر في خصوص كونه قصاصا وعموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة
وثانيها مناسب لا يلائم ولا يشهد له أصل معين فهذا مردود بالإجماع
مثاله حرمان القاتل من الميراث معارضة له بنقيض قصده لو قدرنا أنه لم يرد فيه نص
وثالثها مناسب ملائم لا يشهد له أصل معين بالاعتبار يعنى أنه اعتبر جنسه في جنسه لكن لم يوجد له أصل يدل على اعتبار نوعه في نوعه وهذا هو المصالح المرسلة
ورابعها مناسب شهد له أصل معين ولكنه غير ملائم أي شهد نوعه لنوعه لكن لم يشهد جنسه لجنسه كمعنى الإسكار فإنه يناسب تحريم تناول المسكر صيانة للعقل وقد يشهد لهذا المعنى الخمر بأعتباره لكن لم تشهد له سائر الأصول وهذا هو المسمى بالمناسب الغريب
المسألة الثالثة
في أن المناسبة لا تبطل بالمعارضة والدليل عليه أن كون الوصف مناسبا إنما يكون لكونه مشتملا على جلب منفعة أو دفع مضرة وذلك لا يبطل بالمعارضة أما الأول فظاهر وأما الثاني فيدل عليه وجوه
الأول أن المناسبتين المتعارضتين إما أن تكونا متساويتين أو إحداهما أرجح من الأخرى
فإن كان الأول لم يكن بطلان إحداهما بالأخرى أولى من العكس فإما أن نبطل كل واحدة منهما بالأخرى وهو محال لأن المقتضى لعدم كل واحدة منهما وجود الأخرى والعلة لابد وأن تكون حاصلة مع المعلول فلو كان كل واحدة منهما مؤثرة في عدم الأخرى لزم أن تكونا موجودتين حال كونهما معدومتين وذلك محال
وأما أن لا تبطل إحداهما بالأخرى عند التعارض وذلك هو المطلوب
وأما إن كانت إحدى المناسبتين أقوى فهاهنا لا يلزم التفاسد
أيضا لأنه لو لزم التفاسد لكان لما بينهما من المنافاة لكنا بينا في القسم الأول أنه لا منافاة بينهما لأنهما اجتمعا وإذا زالت المنافاة لم يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر
الثاني أن المفسدة الراجحة إذا صارت معارضة بمصلحة مرجوحة فإما أن ينتفى شيء من الراجح لأجل المرجوح أو لا ينتفي
والأول باطل وإلا لزم أن تكون المفسدة المعارضة بمصلحة مرجوحة مساوية للمفسدة الخالصة عن شوائب المصلحة وذلك باطل بالبديهة
والثاني أيضا باطل
لأن القدر الذي يندفع من المفسدة بالمصلحة يكون مساويا لتلك المصلحة فيعود التقسيم الأول في ذينك التقديرين المتساويين في أنه ليس اندفاع أحدهما بالآخر أولى من العكس فإما أن يندفع
كل واحد منهما بالآخر وهو محال أو لا يندفع واحد منهما بالآخر وهو المطلوب
وأيضا فليس اندفاع بعض أجزاء الطرف الراجح بالطرف المرجوح وبقاء بعضه أولى من اندفاع ما فرض باقيا وبقاء ما فرض زائلا لأن تلك الأجزاء متساوية في الحقيقة
الثالث وهو أن تقرر في الشرع إثبات الأحكام المختلفة نظرا إلى الجهات المختلفة مثل الصلاة في الدار المغصوبة فأنها من حيث أنها صلاة سبب الثواب ومن حيث أنها غصب سبب العقاب والجهة المقتضية للثواب مشتملة على المصلحة والجهة المقتضية للعقاب مشتملة على المفسدة
وعند ذلك نقول المصلحة والمفسدة أما أن يتساويا أو تكون إحداهما راجحة على الأخرى
فعلى تقدير التساوي يندفع كل واحد منهما بالآخر فلا تبقى لا مصلحة ولا مفسدة فوجب أن لا يترتب عليها لا مدح ولا ذم وقد فرضنا ترتبهيا عليها هذا خلف
وإن كانت إحدى الجهتين راجحة كانت المرجوحة معدومة فيكون الحاصل إما المدح وحده أو الذم وحده وقد فرضنا حصولهما معا وهذا خلف
واعلم أن هذا الوجه مبنى على قول الفقهاء الصلاة في الدار المغصوبة عبادة من وجه معصية من وجه
الرابع العقلاء يقولون في فعل معين الإتيان به مصلحة في حقى لولا ما فيه من المفسدة الفلانية ولولا صحة إجتماع وجهى المفسدة والمصلحة وإلا لما صح هذا الكلام والله أعلم
الفن الثاني من هذا الفصل
في إقامة الدلالة على أن المناسبة دالة على العلية فنقول المناسبة تفيد ظن العلية والظن واجب اعمل بهبيان الأول من وجهين
الأول أن الله تعالى شرع الأحكام لمصلحة العباد وهذه مصلحة فيحصل ظن أن الله تعالى إنما شرعه لهذه المصلحة فهذه مقدمات ثلاث لا بد من إثباتها بالدليلأما المقدمة الأولى فالدليل عليها وجوه
أحدها أن الله تعالى خصص الواقعة المعينة بالحكم المعين لمرجح أو لا لمرجحوالقسم الثاني باطل وإلا لزم ترجيح أحد الطرفين على الآخر لا لمرجح وهذا محال فثبت القسم الأول
وذلك المرجح إما أن يكون عائدا إلى الله تعالى أو إلى العبد
والأول باطل بإجماع المسلمين فتعين الثاني وهو أنه تعالى إنها شرع الأحكام لأمر عائد إلى العبد والعائد إلى العبد إما أن يكون مصلحة العبد أو مفسدته أو ما لا يكون مصلحته ولا مفسدته
والقسم الثاني والثالث باطل باتفاق العقلاء فتعين الأول فثبت أنه تعالى إنما شرع الأحكام لمصالح العباد
وثانيها أنه تعالى حكيم بإجماع المسلمين والحكم لا يفعل إلا لمصلحة فإن من يفعل لا لمصلحة يكون عابثا والعبث على الله تعالى محال للنص والإجماع والمعقول
أما النص فقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ربنا ما خلقت هذا باطلا وما خلقناهما إلا بالحق
وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أنه تعالى ليس بعابث
وأما المعقول فهو أن العبث سفه والسفه صفة نقص والنقص على الله تعالى محال
فثبت أنه لا بد من مصلحة وتلك المصلحة يمتنع عودها إلى الله تعالى كما بينا فلابد من عودها إلى العبد
فثبت أنه تعال شرع الأحكام لمصالح العباد
وثالثها أن الله تعالى خلق الآدمي مشرفا مكرما لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم ومن كرم أحدا ثم سعى في تحصيل مطلوبه كان ذلك السعي ملائما لأفعال العقلاء مستحسنا فيما بينهم فإذن ظن كون المكلف مكرما يقتضى ظن أن الله تعالى لا يشرع إلا ما يكون مصلحة له
ورابعها أن الله تعالى خلق الآدميين للعبادة لقوله تعالى وما خلقت الجن
والأنس إلا ليعبدون والحكيم إذا أمر عبده بشيء فلا بد وأن يزيح عذره وعلته ويسعى في تحصيل منافعه ودفع المضار عنه ليصير فارغ البال فيتمكن من الاشتغال بأداء ما أمره به والاجتناب عما نهاه عنه فكونه مكلفا يقتضى ظن أن الله تعالى لا يشرع إلا ما يكون مصلحة له
وخامسها النصوص الدالة على أن مصالح الخلق ودفع المضار عنهم مطلوب الشرع قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال خلق لكم ما في الأرض جميعا
وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا
وقال يريد
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
وقال عز و جل وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال عليه الصلاة و السلام بعثت بالحنيفية السهلة السمحة وقال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
وسادسها أنه وصف نفسه بكونه رءوفا رحيما بعباده وقال ورحمتي وسعت كل شيء فلو شرع ما لا يكون للعبد فيه مصلحة لم يكن ذلك رأفة ولا رحمة
فهذه الوجوه الستة دالة على أنه تعالى ما شرع الأحكام إلا لمصلحة العباد
ثم أختلف الناس بعد ذلك
أما المعتزلة فقد صرحوا بحقيقة هذا المقام وكشفوا الغطاء عنه وقالوا إنه يقبح من الله تعالى فعل القبيح وفعل العبث بل يجب أن يكون فعله مشتملا على جهه مصلحة وغرضوأما الفقهاء فإنهم يصرحون بأنه تعالى إنما شرع هذا الحكم لهذا المعنى ولأجل هذه الحكمة ولو سمعوا لفظ الغرض لكفروا قائله مع أنه لا معنى لتلك اللام إلا الغرض
وأيضا فإنهم يقولون إنه وإن كان لا يجب على الله تعالى رعاية المصالح إلا أنه تعالى لا يفعل إلا ما يكون مصلحة لعباده تفضلا منه وإحسانا لا وجوبا فهذا هو الكلام في تقرير هذه المقدمة
أما المقدمة الثانية وهى أن هذا الفعل مشتمل على هذه الجهة من المصلحة فظاهر لأنا إنما نحكم بعلية الوصف إذا بينا كونه كذلك
أما المقدمة الثالثة وهى أنا لما علمنا أنه لا يشرع إلا لمصلحة وعلمنا أن هذا المعنى مصلحة حصل لنا ظن أن الداعي له تعالى إلى شرع ذلك الحكم هو هذه المصلحة فقد استدلوا عليه من وجهين
الأول وهو أن المصلحة المقتضية لشرع هذا الحكم إما هذه المصلحة أو غيرها لا جائز أن يكون غيرها لأن ذلك الغير إما أن يقال إنه كان مقتضيا لذلك الحكم في الأزل أو ما كان مقتضيا له في الأزل
والأول باطل وإلا لكان الحكم ثابتا في الأزل لكن التكليف بدون المكلف محال فتعين الثاني وهو أنه ما كان مقتضيا لهذا الحكم في الأزل وذلك يفيد ظن استمرار هذا السلب لما سنبين إن شاء الله تعالى أن العلم بوقوع أمر على وجه مخصوص يقتضى
ظن بقائه على ذلك الوجه أبدا وإذا ثبت ظن أن غير هذا الوصف ليس علة لهذا الحكم ثبت ظن أن هذا الوصف هو العلة لهذا الحكم ونحن ما ادعينا إلا الظن
الثاني أن الظن بكون الحاكم حكيما مع العلم بأن هذا الحكم فيه هذه الجهة من الحكمة يفيد في الشاهد ظن أن ذلك الحكيم إنما شرع ذلك الحكم لتلك الجهة وإذا كان الأمر كذلك في الشاهد وجب أن يكون الغائب مثله
بيان المقام الأول أنا إذا اعتقدنا في ملك البلدة أنه لا يفعل فعلا إلا لحكمة فإذا رأيناه يدفع مالا إلى فقير وعلمنا أن فقره يناسب دفع المال إليه ولم تخطر ببالنا صفة أخرى فيها مناسبة لدفع المال إليه غلب على ظننا أنه إنما دفع المال إليه لفقره
نعم لا ننكر أنه يجوز أن يكون له غرض سوى ما ذكرناه لكنه تجويز مرجوح لا يقدح في ذلك الظن الغالب
أما إذا ظهر وجهان من المناسبة مثل أن كان ذلك الفقير فقيها فهاهنا إن تساوى الوجهان في القوة لا يبقى ظن أنه أعطاه لهذا الوصف أو لذلك أو لهما جميعا
فثبت أن العلم يكون الفاعل حكيما مع العلم بحصول جهة معينة في الحكم ومع الغفلة عن سائر الجهات يقتضي ظن أن ذلك الفاعل إنما فعل لتلك الحكمة
بيان المقام الثاني أن في الشاهد دار ذلك الظن مع حصول ذينك العلمين وجودا وعدما والدوران دليل العلية ظاهرا فيحصل ظن أن العلم بكون الفاعل حكيما مع العلم باشتمال هذا الفعل على جهة
مصلحة ومع الغفلة عن سائر الجهات علة لحصول الظن بأن ذلك الحكيم إنما أتى بذلك الفعل لتلك الحكمة والعلة أينما حصلت حصل الحكم
فإذا حصل ذلك العلمان في أفعال الله تعالى وأحكامه وجب أن يحصل ظن أنه تعالى إنما شرع ذلك الحكم لتلك المصلحة فثبت بهذا أن المناسبة تفيد ظن العلية
الوجه الثاني في بيان أن المناسبة تفيد ظن العلية أن نسلم أن أفعال الله
وأحكامه يمتنع أن تكون معللة بالدواعي والأغراض ومع هذا فندعى أن المناسبة تفيد ظن العليةوبيانه أن مذهب المسلمين أن دوران الأفلاك وطلوع الكواكب وغروبها وبقائها على أشكالها وأنوارها غير واجب ولكن الله تعالى لما أجرى عادته بإبقائها على حالة واحدة لا جرم يحصل ظن أنها تبقى غدا وبعد غد على هذه الصفات وكذلك نزول المطر
عند الغيم الرطب وحصول الشبع عقيب الأكل والرى عقيب الشرب والأحتراق عند مماسة النار غير واجب لكن العادة لما اطردت بذلك لا جرم حصل ظن يقارب اليقين بأستمرارها على مناهجها
والحاصل أن تكرير الشيء مرارا كثيرة يقتضى ظن أنه متى حصل لا يحصل إلا على ذلك الوجه
إذا ثبت هذا فنقول إنا لما تأملنا الشرائع وجدنا الأحكام والمصالح متقارنين لا ينفك أحدهما عن الآخر وذلك معلوم بعد استقرار أوضاع الشرائع
وإذا كان كذلك كان العلم بحصول هذا مقتضيا ظن حصول الآخر وبالعكس من غير أن يكون أحدهما مؤثرا في الآخر وداعيا إليه
فثبت أن المناسبة دليل العلية مع القطع بأن أحكام الله تعالى لا تعلل بالأغراض
أما المقدمة الثانية من أصل الدليل وهي أن المناسبة لما أفادت ظن العلية وجب أن يكون ذلك القياس حجة فألاعتماد فيه
على ما ذكرنا أن العمل بالظن واجب لما فيه من دفع الضرر عن النفس وهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل
فإن قيل لا نسلم أن الله تعالى شرع الأحكام لمصلحة
العباد قوله تخصيص الصورة المعينة بالحكم المعين لا بد وأن يكون لمرجح وذلك المرجح يمتنع أن يكون عائدا إلى الله تعالى فلا بد وأن يكون عائدا إلى العبد
قلنا إما أن تدعى أن التخصيص لا بد له من مخصص أو لا تدعى ذلك وعلى التقديرين لا يمكنك القول بتعليل أحكام الله تعالى بالمصالح
أما على القول بأن التخصيص لابد له من مخصص فلأن أفعال العباد إما أن تكون واقعة بالله تعالى أو العبد
فإن كان الأول كان الله تعالى فاعلا للكفر والمعصية ومع القول بذلك يستحيل القول بأنه لا يفعل إلا ما يكون مصلحة العبد
وإن كانت واقعة بالعبد فالعبد الفاعل للمعصية مثلا إما أن يكون متمكنا من تركها أو لا يكون
فإن لم يكن متمكنا من تركها وتلك القدرة والداعية مخلوقة لله تعالى كان الله تعالى قد خلق في العبد ما يوجب المعصية ويمتنع عقلا انفكاكه عنها ومع هذا لا يمكن القول بأن الله تعالى يراعي مصالح العباد
وإن كان العبد متمكنا من تركها فنقول لما كان كونه فاعلا للمعصية وتاركا لها أمرين ممكنين لم يترجح أحدهما على الآخر إلا لمرجح لأنا نتكلم الآن تفريعا على تسليم هذه المقدمة فذلك المرجح إن كان من فعل العبد عاد التقسيم الأول
وإن كان من فعل الله تعالى فإما أن يجب الترجيح عند حصول ذلك المرجح من الله تعالى
أولا يجب فإن وجب عاد الأمر إلى أنه تعالى فعل فيه ما يوجب المعصية ومع هذا لا يمكن القول بأن الله تعالى يراعي المصالح
وإن لم يجب كان حصول الترجيح مع ذلك المرجح ممكنا أن يكون وأن لا يكون فيفتقر إلى مرجح أخر فإما أن يتسلسل وهو محال أو ينتهى إلى الوجوب فيعود الإشكال
فإن قلت عند حصول المرجح يصير الترجيح أولى بالوقوع لكنه لا ينتهى إلى حد الوجوب
قلت حصول الترجيح ولا حصوله مع ذلك القدر من الأولوية إن كانا ممكنين فلنفرض وقوعهما فنسبة ذلك القدر من الأولوية إلى الترجيح واللاترجيح على السواء فأختصاص أحد زماني حصول تلك الأولوية بالوقوع دون الزمان الثاني يكون ترجيحا للممكن المساوى من غير مرجح وهو محال لأنا نتكلم الآن تفريعا على هذه المقدمة
فثبت أن القول بأفتقار التخصيص إلى المخصص يمنع من تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه بالمصالح
وأما أن القول بأن التخصص لا يفتقر إلى المخصص يمنع من القول بتعليل أفعال الله تعالى وأحكامه بالمصالح فذلك ظاهر
فثبت أن تعليل أحكام الله تعالى بالمصالح باطل
وهذا الكلام كما أنه اعتراض على ما قالوه فهو دلالة قاطعة ابتداء في المسألة وبه يظهر فساد سائر الوجوه التي عولوا عليها لأنها أدلة ظنية وما ذكرناه برهان قاطع
ثم نقول إن دل على ما ذكرتموه على أن تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح واقع فمعنا أدلة قاطعة مانعة منه وهي من وجوه
الأول أنه خالق أفعال العباد وذلك يمنع من القول بأنه تعالى يراعي المصالح
إنما قلنا إنه تعالى خالق أفعال العباد لوجوه
أحدها أن العبد لو كان موجدا لأفعاله لكان عالما بتفاصيل أفعاله واللازم باطل فالملزوم مثله
بيان الملازمة أن فعل العبد واقع على كيفية مخصوصة وكمية مخصوصة مع جواز وقوعه على خلاف تلك الكيفية والكمية فلابد وأن يكون ذلك الاختصاص لمخصص إذ لو عقل الاختصاص لا لمخصص لعقل اختصاص حدوث العالم بوقت معين وقدر معين مع جواز وقوعه لاعلى هذا الوجه لا لمخصص وذلك يقتضى القدح في
دليل إثبات الصانع فثبت أنه لابد لفعل العبد من مخصص والتخصيص مسبوق بالعلم فإن التخصيص عبارة عن القصد إلى إيقاعه على ذلك الوجه والقصد إلى إيقاعه على ذلك الوجه مشروط بالشعور بذلك الوجه فالغافل ع الشيء استحال منه القصد إلى إيقاعه
فثبت أنه لوه كان موجودا لأفعال نفسه لكان عالما بتفاصيل أفعاله وإنما قلنا إنه غير عالم بتفاصيل أفعاله لأن النائم فاعل مع انه لا يخطر بباله شيء من تلك التفاصيل بل اليقظان يفعل أفعالا كثيرة مع أنه لا يخطر بباله كيفية تلك الأفعال فإن من فعل حركة بطيئة فذلك البطؤ إما أن يكون عبارة عن تحلل السكنات أو عن كيفية قائمة بالحركة
فإن كان الأول فالفاعل للحركة البطيئة فاعل في بعض الأحياز حركة وفي بعضها سكونا مع أنه لم يخطر بباله ذلك
وإن كان الثاني كان قد فعل حركة وفعل فيها عرضا آخر ثم ذلك البطؤ له درجات مختلفة فهو قد فعل عرضا مخصوصا في عرض آخر مع جواز أن يحصل سائر مراتب البطء مع أنه لم يخطر بباله شيء من ذلك فعلمان أنه قد يفعل ما لم يخطر بباله
فثبت بهذه الدلالة أن العبد غير موجد لأفعال نفسه
الثاني أن موجد العبد مقدور لله تعالى فيجب وقوعه بقدرة الله تعالى
إنما قلنا إن مقدور العبد لله تعالى لأنه في نفسه ممكن والإمكان مصحح للمقدورية
وإنما قلنا إنه لما كان مقدورا لله تعالى وجب وقوعه بقدرة الله تعالى لأنا لو قدرنا قدرة العبد صالحة للإيجاد فإذا فرضنا أن كل واحد منهما أراد الإيجاد فحينئذ يجتمع على ذلك الفعل مؤثران مستقلان بالإيجاد وذلك محال لأن الأثر مع المؤثر المستقل به يصير واجب الوقوع وكل ما كان واجب الوقوع في نفسه استحال استناده إلى غيره
وحينئذ يلزم أن يستغنى بكل واحد منهما عن كل واحد
منهما فيلزم انقطاع ذلك المقدور عنهما حال استناده إليهما معا وهو محال
والثالث إذا فرضنا أن العبد أراد تحريك المحل حالما أراد الله تعالى تسكينه فإذا كانت قدرة العبد مستقلة في الإيجاد وقدرة الله تعالى أيضا مستقلة به لم يكن وقوع أحد المقدورين أولى من وقوع الآخر فإما أن يمتنعا وهو محال لأن المانع من وجود كل واحد منهما وجود الآخر فالمانع حاصل حال تحقق الامتناع فيلزم وجودهما عند عدمهما وهو محال
أو يقعان جميعا فيلزم حصول الضدين وهو محال
فإن قلت قدرة الله تعالى أقوى فكانت أولى بالتأثير
قلت إنها أقوى بمعنى أنها مؤثرة في أمور أخر لا تؤثر فيها قدرة العبد أما فيما يرجع إلى التأثير في ذلك المقدور الواحد فيستحيل
التفاوت لأن ذلك المقدور شيء واحد لا يقبل التفاوت وإذا لم يكن هو في نفسه قابلا للتفاوت استحال وقوع التفاوت في التأثير فيه
الرابع لو قدر العبد على بعض المقدورات الممكنات لقدر على الكل لأن المصحح للمقدورية ليس إلا الأمكان وهو قضية واحدة فيلزم من الاشتراك فيه الاشتراك في المقدورية لكنه غير قادر على كل الممكنات لأنه لا يقدر على خلق السماوات والأرض فوجب أن لا يقدر على الإيجاد ألبتة
فثبت بمجموع هذه الوجوه أن العبد غير موجد لأفعاله بل موجدها هو الله عز و جل
وإذا كان كذلك فكل ما حصل من الكفر والمعاصي فهو من فعل الله تعالى ولا شك أن الغالب على أهل العالم الكفر والمعاصي ومع هذا القول لا يمكن القول بأن الله تعالى لا يفعل إلا ما يكون مصلحة للعبد
فإن قلت هب أن الله تعالى هو الخالق لفعل العبد ولكن المكلف مخير في اختيار الكفر والأيمان والله تعالى أجرى عادته أن يخلق الشيء على وفق اختيار المكلف فإن اختار المكلف الكفر خلق فيه الكفر وإن اختار الأيمان خلق فيه الأيمان فمنشأ المفسدة هو اختيار المكلف
قلت حصوله اختيار الكفر بدلا عن اختيار الأيمان أن كان من المكلف لا من الله تعالى لم يكن الله تعالى فاعلا لكل أفعال العباد وإن كان من الله تعالى فقد بطل الاختيار وتوجه الإشكال
الدليل الثاني على أنه لا يجوز تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه بالمصالح أن القادر على الكفر إن لم يقدر على الأيمان لزم الجبر وذلك يقدح في رعاية المصالح
وإن قدر عليهما فلابد وأن ينتهى إلى مرجح واقع بفعل الله تعالى وعند حصول ذلك المرجح يجب وقوع الكفر فيكون الجبر لازما وذلك يقدح في رعاية المصالح وتقرير هذا الوجه قد تقدم
الدليل الثالث أنه قد وقع التكليف بما لا يطاق وذلك يمنع من القول برعاية المصالح
بيان الأول من وجوه
الأول أنه كلف بالأيمان من علم أنه لا يؤمن فصدور الأيمان منه يستلزم انقلاب العلم جهلا وهذا الانقلاب محال والمفضى إلى المحال محال فكان هذا التكليف تكليفا بالمحالوثانيها أنه إما أن يكلفه حال استواء الدواعي إلى الفعل والترك أو حال رجحان أحدهما على الآخر
والأول محال لأن الاستواء ما دام يكون حاصلا امتنع الرجحان فالأمر بالترجيح حال حصول الاستواء أمر بالجمع بين الضدين
والثاني محال لأن حال الترجيح يكون الراجح واجب الوقوع والمرجوح ممتنع الوقوع فحال الرجحان إن كان مأمورا بترجيح المرجوح كان مأمورا بالجمع بين الضدين
وإن كان مأمورا بترجيح الراجح كان مأمورا بإيقاع الواقع وكل ذلك تكليف بما لا يطاق
وثالثها القدرة إذا حصلت في العبد فإما أن يؤمر بإيقاع الفعل في ذلك الزمان أو في الزمان الثاني
والأول محال لأنه إذا وجد المقدور في ذلك الزمان فلو أمر الله تعالى العبد بإيقاعه في ذلك الزمان كان هذا أمرا بإيجاد الموجود وأنه محال
والثاني أيضا محال لأنه في الزمان الأول لما لم يكن متمكنا من الفعل ألبتة كان أمره بالفعل أمرا لمن لا يقدر
فإن قلت إنه ما أمره في الحال بإيقاع الفعل في الحال حتى يلزم ما قلته بل أمره في الحال بأن يوقعه في الزمان الثاني
قلت هل لقولك يوقعه مفهوم زائد على الفعل أم لا فإن لم يكن له مفهوم زائد لم يكن لقولك إنه أمره في الحال بإيقاع الفعل في الزمان الثاني معنى إلا أنه أعلم في الحال بأنه لا بد وأن يكون في الزمان بحيث يصدر عنه الفعل ففي هذا الزمان لم يحصل إلا الإعلام فأما الإلزام فلا يحصل إلا في الزمان الثاني فيعود الأمر إلى أنه أمره بإيقاع الفعل حال وقوعه فيه
وإن كان لقولك يوقعه مفهوم زائد على مفهوم الفعل فذلك الزائد هل حصل في الزمان الأول أو ما حصل
فإن حصل في الزمان الأول وقد أمر في الزمان الأول به فحينئذ يلزم كونه مأمورا بالشيء حال حصوله
وإن لم يحصل في الزمان الأول بل في الزمان الثاني عاد ما ذكرنا من أن الحاصل في الزمان الأول إعلام لا إلزام
والإلزام لا يحصل إلا في الزمان الثاني فيعود ما ذكرنا من أنه أمر بالفعل حال وقوعه
ورابعها أن الله تعالى قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فأولئك الذين أخبر الله عنهم بهذا الخبر كانوا مأمورين بالإيمان ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه فإذن كانوا مأمورين بأن يصدقوا الله تعالى في إخباره عنهم بأنهم لا يؤمنون ألبتة وذلك تكليف ما لا يطاق
وخامسها ما بينا أن فعل العبد لا يحصل إلا إذا خلق الله فيه داعية تلجئه إلى فعله إلجاءا ضروريا فالكافر إذن ملجأ إلى فعل الكفر فإذا كلف بالإيمان كان ذلك تكليف ما لا يطاق
وسادسها أن الله تعالى أمر بمعرفته وذلك تكليف ما لا يطاق لأن الأمر إما أن يتوجه إلى العبد حال كونه عارفا بالله تعالى أولا في هذه الحالة
فإن كان الأول كان العارف مأمورا بتحصيل المعرفة فيكون ذلك أمرا بتحصيل الحاصل وهو محال
وإن كان الثاني فحال كونه غير عارف بالله تعالى استحال أن يكون عارفا بأمر الله تعالى فحال كونه بحيث يستحيل عليه أن يعرف أمر الله تعالى لما توجه عليه الأمر كان كذلك تكليفا بما لا يطاق
وسابعها أنا أمرنا بالترك والأمر بالترك أمر بما لا قدرة كنا عليه لأنا إذا تركنا الفعل فلا معنى لهذا الترك إلا أنه بقى معدوما كما كان والعدم المستمر لا قدرة لنا عليه
وبيانه من وجهين
الأول أن العدم نفى محض والقدرة مؤثرة فالجمع بينهما متناقضوثانيهما أن العدم لما كان مستمرا لا يمكن التأثير فيه لأن التأثير في الباقي محال
فإن قلت الترك عندي أمر وجودى وهو فعل الضد قلت الإلزام هاهنا قائم لأنا الواحد منا قد يؤمر بترك الشيء الذي لا يعرف للى ضدا فلو أمرنا في ذلك الوقت بفعل ضده لكنا قد أمرنا بفعل شيء لا نعرف ماهيته فيكون ذلك أيضا قولا بتكليف مالا يطاق
فثبت بهذه الوجوه السبعة وقوع تكليف مالا يطاق ولا شك أن ذلك يقدح في تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه في مصالح العباد
الدليل الرابع
أن تخصيص خلق العالم بالوقت الذي خلق فيه دون ما قبله وما بعده يستحيل أن يكون معللا بغرض لأن قبل حدوث العالم لا وقت ولازمان بل ليس إلا الله تعالى والعدم الصرف ويستحيل أن يحصل في العدم الصرف وقت يكون منشأ المصالح ووقت أخر يكون منشأ المفاسد
الدليل الخامس
أن تقدير السماوات والكواكب المعينة وتقدير البحار والأرضين بمقاديرها المعينة لا يجوز أن يكون رعاية لغرض الخلق فإنا نعلم أنه لو ازداد في خلق الفلك الأعظم مقدار جزءا لا يتجزأ فإنه لا يتغير بذلك ألبتة شيء من مصالح المكلفين ولا من مفاسدهمالدليل السادس
أنه تعالى خلق الكافر الفقير بحيث يكون في الدنيا من أول عمره إلى آخر عمره في المحنة وفي الآخرة يكون في أشد العذاب أبدا الآبدين ودهر الداهرين وأنه تعالى كان عالما من الأزل إلى الأبد أنه إذا خلقه وكلفه بالإيمان فإنه لا يستفيد من الخلقوالتكليف إلا زيادة المحنة والبلاء فكيف يقال إنه تعالى لا يفعل إلا ما يكون مصلحة للمكلف
الدليل السابع
أنه تعالى خلق الخلق وركب فيهم الشهوة والغضب حتى أن بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يضجر ببعض ولقد كان تعالى قادرا على أن يخلقنا في الجنة إبتداء ويغنينا بالمشتهيات الحسنة عن القبيحةفإن قلت إنه تعالى إنما فعل ذلك ليعطيه العوض في الآخرة وليكون لطفا لمكلف آخر
قلت أما العوض فلو أعطاه ابتداء كان أولى وأما اللطف فأى عاقل يرضى أن يقال إنما حسن إيلام هذا الحيوان ليكون لطفا بذلك الحيوان
الدليل الثامن
دلت الوجوه المذكورة في أول هذا القسم على أنه يستحيل أن يكون شيء من أفعاله وأحكامه معللا بالمصالح فظهر بهذه الوجوه انه ليس الغالب في أفعال الله تعالى رعاية مصالح الخلقوإذا كان كذلك لم يغلب على الظن أن أحكامه معللة بمصالح الخلق فإنا إذا رأينا شخصا يكون أغلب أفعاله رعاية المصالح ثم رأيناه حكم بحكم غلب على ظننا اشتمال ذلك الحكم على مصلحة
أما إذا رأينا شخصا يكون أغلب أفعاله عدم الالتفات إلى المصالح ثم رأيناه حكم بحكم فإنه لا يغلب على ظننا اشتمال ذلك الحكم على مصلحة ألبتة هذا في حق الإنسان الذي يكون محتاجا إلى رعاية المصلحة
أما الإله سبحانه وتعالى لما كان منزها عن المصالح والمفاسد بالكلية ثم رأينا أن الغالب في أفعاله ما لا يكون مصلحة للخلق كيف يغلب على الظن كون أفعاله وأحكامه معللة بالمصالح
سلمنا أن أحكامه تعالى معللة بالمصالح وأن هذا الفعل
مصلحة من هذا الوجه فلم قلت إن هذا القدر يقتضى ظن كون ذلك الفعل معللا بهذه المصلحة
أما الوجه الأول فالاعتماد فيه على أن الاستصحاب يفيد الظن
وأما الوجه الثاني فالاعتماد فيه على أن الدوران يفيد الظن والكلام في هذين الموضعين سيأتي إن شاء الله تعالى
ثم نقول على الوجه الثاني خاصة لم قلت لما حصل الظن في المثال المذكور وجب حصوله في حق الله تعالى
قوله الدوران يفيد الظن
قلنا لكن بشرط أن لا يظهر وصف آخر في الأصل وهاهنا قد وجد
بيانه من وجهين
الأول أنا إنما حكمنا بذلك في حق الملك لعلمنا بأن طبعه يميل إلى جلب المصالح ودفع المفاسد وذلك في حق الله تعالى مفقود الثاني أن المعتبر ليس دفع عموم الحاجة بل دفع الحاجة المخصوصة فمن عرف عادة الملك وأنه يراعي عادة هذا النوع أو ذاك لا جرم يحصل له ظن أن غرض الملك من هذا الفعل هذا المعنى أو ذاك
وأما عادات الله تعالى في رعاية أجناس المصالح وأنواعها فمختلفة ولذلك قد يكون الشيء قبيحا في عقولنا وإن كان حسنا عند الله تعالى وقد يكون بالعكس ولهذا المعنى انقطع الآن بقبح جميع الشرائع الواردة في زمان موسى وعيسى عليهما السلام وبحسن شريعتنا وإن كان التفاوت غير معلوم لنا الآن
وإذا كان كذلك ظهر الفرق بين الصورتين
سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على قولكم لكنه معارض بأمور
أحدها أن أفعال الله تعالى وأحكامه لو كانت لدفع حاجة العبد لكانت الحاجات بأسرها مدفوعة واللازم باطل فالملزوم مثله
بيان الملازمة أن الحاجات المختلفة مشتركة في أصل كونها حاجات ومتباينة بخصوصياتها وما به الاشتراك غير ما به الامتياز فما به يمتاز كل واحد من أنواع الحاجة عن الآخر منها لا يكون حاجة
وإذا كان كذلك كان التعليل بكونه حاجة يوجب سقوط تلك الزوائد عن العلية وارتباط الحكم بمسمى الحاجة الذي هو القدر المشترك بين كل أنواعه فإذا كان ذلك المسمى علة لشرع ما يصلح أن يكون دافعا له لزم من هذا كون جميع الحاجات مدفوعة ولما لم يكن كذلك علمنا أن التعليل بالحاجة غير جائز
وثانيها أن تعليل أحكام الله تعالى بالمصالح يفضى إلى مخالفة الأصل وذلك لأن العبادات التي كانت مشروعة في زمان موسى وعيسى
عليهما السلام كانت واجبة وحسنة في تلك الأزمنة وصارت قبيحة في هذا الزمان فلابد وأن يكون ذلك لأ حصل شرط في ذلك الزمان لم يحصل الآن أو وجد الآن مانع ما كان موجودا في ذلك الزمان لكن توقف المقتضي على وجود الشرط أو تخلف حكمه لأجل المانع خلاف الأصل
وثالثها أن الحكم إما أن يكون معللا بنفس الحكمة أو بالوصف المشتمل على الحكمة
والأول باطل لأن الحكمة غير مضبوطة فلا يجوز ربط الأحكام بها
والثاني باطل لأن الوصف إنما يكون علة للحكم لاشتماله على تلك الحكمة فيعود الأمر إلى كون الحكمة علة لعليه الوصف فيعود المحذور المذكور
والجواب
قد بينا أن أحكام الله تعالى مشروعة لأجل المصالحفأما الوجوه العقلية التي ذكرتموها فهي لو صحت لقدحت في التكليف والكلام في القياس نفيا وإثباتا فرع على القول بالتكليف فكانت تلك الوجوه غير مسموعة في هذا المقام
وهذا هو الجواب المعتمد الكافي في هذا المقام عن كل ما ذكرتموه
وأما الفرقان اللذان ذكرتموهما بيبن الشاهد والغائب فذلك إنما يقدح في قول من يقول يجب عقلا تعليل أحكام الله تعالى بالمصالحأما من يقول إن ذلك غير واجب ولكنه تعالى فعله على هذا الوجه تفضلا وإحسانا فذلك الفرق لا يقدح في قوله
وأما المعارضات الثلاث الأخيرة فهي منقوضة بكون أفعالنا
معللة بالدواعي والأغراض مع أن جميع ما ذكروه قائم فيها
الفصل الرابع في المؤثر
وهو أن يكون الوصف مؤثرا في جنس الحكم في الأصول دون وصف آخر فيكون أولى بأن يكون علة من الوصف الذي لا يؤثر في جنس ذلك الحكم ولا في عينه وذلك كالبلوغ الذي يؤثر في رفع الحجر عن المال فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيابة لأنها لا تؤثر في جنس هذا الحكم وهو رفع الحجروكقولهم إذا قدم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب في الميراث فينبغي أن يقدم عليه في ولاية النكاح
فإن قلت لم قلت لما أثرت الأخوة من الأب والأم في التقديم في الإرث أثرت في التقديم في النكاح
قلت ذكروا أنه يتبين ذلك بالمناسبة و بأن يقال لا فارق بين الأصل والفرع إلا كذا وهو ملغى
وعند هذا يظهر أن هذه الطريقة لا تمشى إلا بعد الرجوع إلى طريق المناسبة وطريق السبر
الفصل الخامس في الشبه
والنظر في ماهيته ثم في إثباتهأما الماهية فقد ذكروا في تعريفها وجهين
الأول
ما قاله القاضي أبو بكر رحمه الله وهو أنه قال إن الوصف إما أن يكون مناسبا للحكم بذاته
وإما أن لا يناسبه بذاته لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته
وإما أن لا يناسبه بذاته ولا يستلزم ما يناسبه بذاته
فالأول هو الوصف المناسب
والثاني هو الشبه
والثالث هو الطرد
الثاني الوصف الذي لا يناسب الحكم إما أن يكون قد عرف بالنص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم وأما أن لا يكون كذلك
فالأول هو الشبه لأنه من حيث هو غير مناسب يظن أنه غير معتبر في حق ذلك الحكم
ومن حيث علم تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم مع أن سائر الأوصاف ليس كذلك يكون ظن إسناد الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى غيره
واعلم أن الشافعى رضى الله عنه سمى هذا القياس قياس غلبة الأشباه
وهو أن يكون الفرع واقعا بين أصلين فإذا كانت مشابهته لإحدى الصورتين أقوى من مشابهته للأخرى ألحق لا محالة بالأقوى
فأما الذي يقع بين الاشتباه فالمحكى عن الشافعى رضى الله عنه أنه كان يعتبر الشبه في الحكم كمشابهة العبد المقتول للحر ولسائر المملوكات
وعن ابن علية أنه كان يعتبر الشبه في الصورة كرد الجلسة الثانية في الصلاة إلى الجلسة الأولى في عدم الوجوب
والحق أنه متى حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة الحكم أو مستلزم لما هو علة له صح القياس سواء كان ذلك في الصورة أو في الأحكام
النظر الثاني
في أنه حجة قال القاضي أبو بكر ليس بحجةلنا أنه يفيد ظن العلية فوجب العمل به
بيان الأول أنه لما ظن كونه مستلزما للعلية كان الاشتراك فيه يفيد ظن الاشتراك في العلةوعلى التفسير الثاني
أنه لما ثبت أن الحكم لابد له من علة وأن العلة إما هذا الوصف وإما غيره ثم رأينا أن جنس هذا الوصف أثر في جنس ذلك الحكم ولم يوجد هذا المعنى في سائر الأوصاف فلا شك أن ميل القلب إلى إسناد الحكم إلى هذا الوصف أقوى من ميله إلى إسناده إلى غير ذلك الوصف وإذا ثبت أنه يفيد الظن وجب أن يكون حجة لما بينا أن العمل بالظن واجب
واحتج القاضي بوجهين
الأول الوصف الذي سميتموه شبها إن كان مناسبا فهو معتبر بالاتفاق وإن كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق
الثاني أن المعتمد في إثبات القياس عمل الصحابة ولم يثبت عنهم أنهم تمسكوا بالشبه
والجواب عن الأول لا نسلم أن الوصف إذا لم يكن مناسبا كان مردودا بالاتفاق بل ما لا يكون مناسبا إن كان مستلزما للمناسب أو عرف بالنص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو عندنا غير مردود وهذا أول المسألة
وعن الثاني أنا نعول في إثبات هذا النوع من القياس على عموم قوله تعالى فاعتبروا أو على ما ذكرنا أنه يجب العمل بالظن و الله اعلم
الفصل السادس في الدوران
ومعناه أن يثبت الحكم عند ثبوت وصف وينتفى عند انتفائه وذلك يقع في وجهينالأول أن يقع ذلك في صورة واحدة فأن العصير لما لم يكن مسكرا في أول الأمر لم يكن حراما فلما حدث وصف الإسكار فيه حدثت الحرمة فلما صار خلا وزالت المسكرية زالت الحرمة أيضا
الثاني أن يوجد ذلك في صورتين وعندنا أنه يفيد ظن العلية وقال قوم من المعتزلة إنه يفيد يقين العلية
وقال آخرون إنه لا يفيد يقين العلية و ظنها
لنا وجهان
الأول أن هذا الحكم لا بد له من علة والعلة إما هذا الوصف أو غيره والأول هو المطلوبوالثاني لا يخلو إما أن يكون ذلك الغير كان موجودا قبل حدوث هذا الحكم أو ما كان موجودا قبله
فإن كان موجودا قبله وما كان هذا الحكم موجودا لزم تخلف الحكم عن العلة وهو خلاف الأصل
وإن لم يكن موجودا فالأصل في الشيء بقاؤه على ما كان فيحصل ظن أنه بقي كما كان غير علة وإذا حصل ظن أن غيره ليس بعلة حصل ظن كون هذا الوصف علة لا محالة
فإن قلت ذلك الحكم كما دار مع حدوث ذلك الوصف وجودا وعدما فكذلك دار مع تعين ذلك الوصف ومع حدوث حصول ذلك الوصف في ذلك المحل فيجب أن يكون تعينه وحدوثه في ذلك المحل معتبرا في العلية وذلك يمنع من التعدية
قلت تعين الشيء معناه أنه ليس غيره وهذا أمر عدمي إذ لو كان وجوديا لكان ذلك الوجود مساويا لسائر التعينات القائمة
بسائر الذوات في كونه تعينا ويمتاز عنها بخصوصيته فيلزم أن يكون للتعيين تعين آخر إلى غير نهاية وهو محال
وأما حصول الوصف في ذلك المحل فيستحيل أن يكون أمرا وجوديا وإلا لكان ذلك وصفا لذلك الوصف فكونه وصفا للوصف زائد عليه فيلزم التسلسل
وإذا ثبت أن التعين أمر عدمي والحصول في المحل المعين أمر عدمي استحال كونه علة ولا جزء علة
أما أنه لا يكون علة فلأنا قولنا في الشيء المعين إنه علة نقيض لقولنا إنه ليس بعلة وقولنا إنه ليس بعلة يصح وصف المعدوم به في الجملة ووصف المعدوم لا يكون موجودا فقولنا ليس بعلة أمر عدمي وقولنا علة مناقض له ومناقض العدم ثبوت فمفهوم قولنا علة أمر ثبوتى
فلو وصفنا العدم به لزم قيام الصفة الموجودة بالموصوف الذي هو نفى محض وذلك محال
وأما أنه لا يجوز أن يكون جزء علة فلأنا لو فرضنا حصول سائر الأجزاء بدون هذا الجزء الواحد فإما أن تحصل العلية أو لا تحصل فإن حصلت العلية كان سائر الأجزاء دون هذا الجزء تمام العلة فلا يكون هذا الجزء جزء العلة
وإن لم تحصل العلية عند عدم هذا الجزء وحصلت عند حصوله كانت العلية إنما حدثت لأجل هذا الجزء فجزء العلة علة تامة لعلية العلة وقد عرفت أن العدم لا يكون علة فوجب أن لا يكون العدم جزءا من العلة وهو المطلوب
الوجه الثاني أن الدوران يفيد ظن العلية
وهو أن بعض الدورانات يفيد ظن العلية فوجب أن يكون كل دوران كذلك مفيدا لهذا الظنبيان الأول أن من دعى بأسم فغضب ثم تكرر الغصب مع تكرر الدعاء بذلك الاسم حصل هناك ظن أنه إنما غضب لأنه دعى بذلك الاسم وذلك الظن إنما حصل من ذلك الدوران لأن الناس إذا قيل لهم لم اعتقدتم ذلك قالوا لأجل أنا رأينا الغضب مع الدعاء بذلك الاسم مرة بعد أخرى فيعللون الظن بالدوران
بيان الثاني قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان
والعدل هو التسوية ولن تحصل التسوية بين الدورانات إلا بعد اشتراكها في إفادة الظن
واحتج المنكرون بأمرين
الأول أن بعض الدورانات لا يفيد ظن العلية فوجب أن لا يفيد شيء منها ظن العلية
بيان الأول من وجوه
أحدها أن العلة والمعلول قد يكونان متلازمين نفيا وإثباتا والدوران مشترك بين الجانبين والعلة غير مشتركة بين الجانبين لأن المعلول لا يكون علة لعلته
وثانيها أن الفصل لابد أن يكون مساويا للنوع والنوع إذا أوجب حكما فالدوران كما حصل مع العلة التي هي النوع حصل مع الفصل الذي هو جزء العلة مع أن جزء العلة ليس بعلة
وثالثها أن العلة قد يكون اقتضاؤها للمعلول موقوفا على شرط فالدوران حاصل مع شرط العلة مع أنه ليس بعلة
ورابعها أن العلة قد يكون لها معلولان إما معا عند من يجوز ذلك أو على الترتيب فالدوران حاصل في علة العلة ومعلول العلة مع أنه لا علية هناك ألبتة
وخامسها أن الجوهر والعرض متلازمان نفيا وإثباتا وذات الله تعالى وصفاته كذلك وكل واحدة من صفاته مع سائر الصفات كذلك ولا علية هناك
وسادسها أن المضافين متلازمان معا نفيا وإثباتا كالأبوة والبنوة والمولى والعبد ويمتنع كون أحدهما على للآخر لأن العلة متقدمة على المعلول والمضافان معا ولا شيء من المع متقدم
وسابعها أن المكان والمتمكن والحركة والزمان لا ينفك واحد منها عن الآخر مع عدم العلية
وثامنها أن الجهات الست لا ينفك بعضها عن بعض مع عدم العلية
وتاسعها أن علم الله تعالى دائر مع كل معلوم وجودا وعدما فإنه لو كان المعلوم جوهرا لعلمه جوهرا ولو لم يكن المعلوم جوهرا فإن الله تعالى لا يعلمه جوهرا فالعلم دائر مع المعلوم وجودا وعدما مع أنه يستحيل أن يكون أحدهما علة للآخر
أما أنه لا يكون العلم علة للمعلوم فلأن شرط كونه علما أن يتعلق بالشيء على ما هو به فما لم يكن المعلوم في نفسه واقعا على ذلك الوجه استحال تعلق العلم به على ذلك الوجه
إذن تعلق العلم به على ذلك الوجه مشروط بوقوعه على ذلك الوجه فلو كان وقوعه على ذلك الوجه متوقفا على تعلق العلم به لزم الدور
واما أنه يستحيل أن يكون المعلوم علة للعلم فلأن علم الله تعالى صفة أزلية واجبة الوجود وما كان كذلك يستحيل أن يكون معلول علة
فثبت أنه وجد الدوران هاهنا بدون العلية
ثم إن علم الله تعالى متعلق بما لا نهاية له من المعلومات فهاهنا دورانات لا نهاية لها بدون العلية
وعاشرها
أن الأعراض عند أهل السنة لا تبقى فهذه الألوان والأشكال تحدث حالا بعد حال فحين فنى ذلك اللون وذلك الشكل عن ذلك الجسم فنيت الألوان والأشكال وسائر الأعراض عن جميع الأجسام وحين حدث فيه لون وشكل حدث فيه سائر الأعراض في جميع الأجسام فقد حصلت هذه الدورانات الكثيرة بدون العلية
وحادى عشرها أن الفلك إذا تحرك تحرك بجميع أجزاءه فحركة كل واحدة من أجزاءه إنما حدثت عند حركة جميع أجزاءه وحين كانت تلك الحركة معدومة عن ذلك الجزء كانت حركات سائر الأجزاء معدومة فقد حصلت هذه الدورانات الكثيرة بدون العلية
وثاني عشرها أن جميع الحيوانات تتنفس ولا شك أن كل واحد منها إما أن يتنفس مع كون الآخر متنفسا أو عقيبه بلحظة قليلة فقد وجدت هذه الدورانات بدون العلية
وثالث عشرها أن الحكم كما دار مع الوصف وجودا وعدما فقد دار أيضا مع تعين الوصف وخصوص المحل وخصوص وقوعه الزمان المعين والمكان المعين وشيء من ذلك لا يصلح للعلية لما ذكرتم أنها أمور عدمية والعدم غير صالح للعلية
ورابع عشرها أن الحد دائر مع المحدود وجودا وعدما والرائحة الفائحة في الخمر دائرة مع الحرمة وجودا وعدما مع أنه لا علية هناك
وأعلم أن لو أردنا استقصاء القول في الدورانات المنفكة عن العلية لطال الكلام ولكن فيما ذكرنا كفاية
وإنما قلنا إن بعض الدورانات لما انفكت عن العلية وجب أن لا يحصل ظن العلية في شيء منها لأنه إذا حصل دوران ما منفكا عن العلية فلو قدرنا أن دورانا آخر يستلزم العلية لكان كونه مستلزما للعلية إما أن يتوقف على انضمام شيء آخر إليه أو لا يتوقف
فإن توقف كان المستلزم للعلية هو المجموع الحاصل من الدوران ومن ذلك الشيء لا الدوران وحده وكلامنا الآن في الدوران وحده
وإن لم يتوقف مع أن مسمى الدوران حاصل في الموضعين جميعا لزم ترجح أحد طرفي الجائز على الآخر لا لمرجح وهو محال هذا تمام تقرير هذا الدليل
الوجه الثاني وهو الذي عول عليه المتقدمون في القدح قالوا الاطراد وحده
ليس طريقا إلى علية الوصف بالاتفاقوأما الانعكاس فأنه غير معتبر في العلل الشرعية وإذا كان كل واحد منهما لا يدل على العلية كان مجموعهما أيضا كذلك
والجواب عن الأول أن ذلك إنما يقدح في قول من يقول الدوران وحده يوجب ظن
العلية ونحن لا نقول به بل ندعى أن الدوران يفيد ظن العلية بشرط أن لا يقوم عليه دليل يقدح في كونه علة وإذا لخصنا الدعوى على هذا الوجه سقط ما ذكرتموه من الاستدلالوعن الثاني لم قلت أن كل واحد منهما لما لم يفد ظن العلية وجب في المجموع أن يكون كذلك فإنا نعلم أن حال المجموع قد يكون مخالفا حال كل واحد من أجزائه
الفصل السابع في السبر والتقسيم
التقسيم إما أن يكون منحصرا بين النفى والإثبات أو لا يكونفالأول هو أن يقال الحكم إما أن يكون معللا أو لا يكون معللا
فإن كان معللا فإما أن يكون معللا بالوصف الفلانى أو بغيره وبطل أن لا يكون معللا أو يكون معللا بغير ذلك الوصف فتعين أن يكون معللا بذلك الوصف
وهذا الطريق عليه التعويل في معرفة العلل العقلية
وقد يوجد ذلك في الشرعيات كما يقال أجمعت الأمة على أن حرمة الربا في البر معللة وأجمعوا على أن العلة إما المال أو
القوت أو الكيل أو الطعم وبطل التعليل بالثلاثة الأولة فتعين الرابع
وكما يقال أجمعت الأمة على أن ولاية الإجبار معللة إما بالصغر وإما بالبكارة
والأول باطل وإلا لثبتت الولاية في الثيب الصغيرة لكنها لا تثبت لقوله عليه الصلاة و السلام الثيب أحق بنفسها من وليها فتعين التعليل بالبكارة
وأما التقسيم المنتشر فكما إذا لم ندع الإجماع بل نقتصر على أن نقول حرمة الربا في البر إما أن تكون معللة بالطعم أو الكيل أو القوت أو المال والكل باطل إلا الطعم فيتعين التعليل به
فإن قيل لا نسلم أن حرمة الربا معللة فإن الأحكام منها
مالا يعلل بدليل أن علية العلة غير معللة وإلا لزم التسلسل
وإذا ثبت هذا فلم لا يجوز أن يقال هذا من جملة مالا يعلل سلمنا كونه معللا فما الدليل على الحصر
فإن قلت لو وجد وصف آخر لعرفه الفقيه البحاث
قلت لعله عرفه لكنه ستره
وأيضا فعدم الوجدان لا يد على عدم الوجود
سلمنا الحصر لكن لا نسلم فساد الأقسام
سلمنا فساد المفردات لكن لم لا يجوز أن يقال مجموع وصفين أو ثلاثة منها علة واحدة
سلمنا فساد سائر الأقسام مفردا ومركبا لكن لم لا يجوز أن ينقسم هذا القسم الثاني إلى قسمين فتكون العلة أحد قسميه فقط
والجواب
لا نزاع في أن التقسيم المنتشر لا يفيد اليقين لكنا ندعي أنه يفيد الظنأما قوله لم لا يجوز أن لا يكون هذا الحكم معللا
قلت لما سبق في باب المناسبة أن الدلائل العقلية والسمعية دلت على تعليل أحكام الله تعالى بالحكم والمصالح فكان هذا الاحتمال مرجوحا
قوله ما الدليل على الحصر
قلنا الجواب عنه من وجهين
الأول أن المناظر تلو الناظر فلو أجتهد الناظر وبحث عن الأوصاف ولم يطلع إلا على القدر المذكور ووقف على فساد كلها إلا على الواحد فلا شك أن حكم قلبه بربط ذلك الحكم بذلك الوصف أقوى من ربطه بغير ذلك الوصف وإذا حصل الظن وجب العمل به
وإذا ثبت ذلك في حق المجتهد وجب أن يكون الأمر كذلك في حق المناظر لأنه لا معنى للمناظرة إلا إظهار مأخذ الحكم
الثاني لو سلمنا أنه لا بد من الدليل على الحصر فنقول لا شك أن جميع الأوصاف كانت معدومة وكانت بحيث يصدق عليها أنها لا توجب هذا الحكم والأصل في كل أمر بقاؤه على ما كان فهذا القدر يفيد ظن عدم سائر الأوصاف فيحصل ظن الحصر ومطلوبنا هاهنا هذا القدر
قوله لا نسلم فساد سائر الأقسام
قلنا يمكن إفسادها بجميع المفسدات من النقض وعدم التأثير وأنواع الأيماءات بلى لا يمكن إفسادها هاهنا بعدم المناسبة لأنه حينئذ يحتاج إلى أن يبين خلو ما تدعيه علة عن هذا المفسد
وذلك لا يتم إلا ببيان مناسبته ولو بين ذلك لاستغنى عن طريقة السبر
قوله لم لا يجوز أن يكون المجموع هو العلة
قلنا لأنعقاد الإجماع على ثبوت الحكم حيث لم يوجد المجموع
قوله لم لا يجوز أن تكون العلة طعما مخصوصا
قلنا لأن كل من اعتبر الطعم لم يعتبر طعما مخصوصا فكان القول به خرقا للإجماع
الفصل الثامن في الطرد
والمراد منه الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب إذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع فهذا هو المراد من الاطراد والجريانوهذا قول كثير من قدماء فقهائنا ومنهم من بالغ فقال مهما رأينا الحكم حاصلا مع الوصف في صورة واحدة حصل ظن العلية
احتجوا على التفسير الأول بوجهين
الأول أن استقراء الشرع يدل على أن النادر في كل باب ملحق بالغالب فإذا رأينا الوصف في جميع الصور المغايرة بمحل النزاع مقارنا للحكم ثم رأينا الوصف حاصلا في الفرع وجب أن يستدل به على ثبوت الحكم إلحاقا لتلك الصورة الواحدة بسائر الصورالثاني أنا إذا رأينا فرس القاضي واقفا على باب الأمير غلب على ظننا كون القاضي في دار الأمير وما ذاك إلا لأن مقارنتهما في سائر الصور أفاد ظن مقارنتهما في هذه الصورة المعينة
احتج المخالف بأمرين
أحدهما أن الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم وهذا لا يثبت إلا إذا ثبت أن الحكم حاصل معه في الفرع فإذا أثبتم حصول الحكم في الفرع بكون ذلك الوصف علة وبينتم عليته بكونه مطردا لزم الدور وهو باطل
وثانيهما أن الحد مع الحدود والجوهر مع العرض وذات الله تعالى مع صفاته حصلت المقارنة فيها مع عدم العلية
الجواب عن الأول أنا لا نستدل بالمصاحبة في كل الصور على العلية حتى يلزم
الدور بل نستدل بالمصاحبة في كل صورة غير الفرع على العلية وحينئذ لا يلزم الدوروعن الثاني أن غاية كلامكم حصول الطرد في بعض الصور منفكا عن العلية وهذا لا يقدح في دلالته على العلية ظاهرا كما أن
الغيم الرطب دليل المطر ثم عدم نزول المطر في بعض الصور لا يقدح في كونه دليلا
وأيضا المناسبة والدوران والتأثير والأيماء قد ينفك كل واحد منها عن العلية ولم يكن ذلك قدحا في كونها دليلا على العلية ظاهرا فكذا هاهنا
وأما التفسير الثاني وهو أضعف التفسيرين فقد احتجوا عليه بأنا إذا علمنا
أن الحكم لابد له من علة وعلمنا حصول هذا الوصف وقدرنا خلو ذهننا عن سائر الأوصاف فإن علمنا بأنه لا بد للحكم من علة مع علمنا بوجود هذا الوصف يقتضيان اعتقاد كون هذا الحكم معللا بذلك الوصف اذا لو لم يقتض ذلك لكان ذلك إما لأجل أنه لا يسند ذلك الحكم إلى شيء أو لأجل أنه يسنده إلى شيء أخروالأول محال لأن اعتقاد أنه لابد من علة متناقض لعدم الاسناد
والثاني محال لأن اسناد الذهن ذلك الحكم إلى غير ذلك الوصف مشروط بشعور الذهن بغير ذلك الوصف وتحقق ذلك حال خلو الذهن عن الشعور بغير ذلك الوصف محال
فثبت بهذا أن مجرد ذينك العلمين يقتضيان ظن العلية بلى عند الشعور بوصف آخر يزول ذلك الظن ولكن الشعور بالغير كالمعارض لما يقتضى ذلك الظن ونفى المعارض ليس على المستدل
حجة المنكرين من وجهين
الأول أن تجويزه يفتح باب الهذيان كقولهم في إزالة النجاسة مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تجوز إزالة النجاسة به كالدهنوقال بعضهم في مسألة اللمس طويل مشقوق فلا تنتقض الطهارة بلمسة كالبوق
الثاني أن تعين الوصف المعين للعلة مع كونه مساويا لسائر الأوصاف قول في الدين لمجرد التشهى فيكون باطلا لقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
والجواب عن الأول أن ذلك الكلام يدل على جهل قائله بصورة المسألة لأنا
نقول مجرد المقارنة يفيد ظن العلية ولكن بشرط أن لا يخطر بالبال وصف آخر هو أولى بالرعاية منه ولكن هذا الشرط ساقط عن المعلل لأن نفى المعارض ليس من وظيفته وفي هذين المثالين إنما يبطل ذلك لأن العلم الضرورى حاصل بوجود وصف أخر هو أولى بالاعتبار من الوصف المذكور لأنا متى علمنا كون الدهن لزجا غير مزيل للنجاسة علمنا أن هذا الوصف أولى بالاعتبار من كونه بحيث لا تبنى القنطرة على جنسه
فإن قلت فهل يكفى في القدح في مثل هذا التعليل خطور وصف آخر بالبال
قلنا لا لأن ذلك الوصف الآخر إما أن يكون متعديا إلى الفرع أو لا يكون
فإن كان متعديا إلى الفرع فلم يضرنا لأن غرضنا من العلة المعرف وقيام معرف آخر لهذا الحكم لا يمنع من كون ما ذكرته معرفا له
وإن لم يكن متعديا إلى الفرع كان التعليل بالوصف الذي ذكرته أولى لأنا أمرنا بالقياس في قوله تعالى فاعتبروا والأمر بالقياس أمر بما هو من ضروراته ومن ضرورات القياس تعليل
حكم الأصل بعلة متعدية فكان التعليل بما ذكرناه أولى من التعليل بما ذكره الخصم اللهم إلا أن يذكر الخصم وصفا آخر ويعديه إلى فرع غير الفرع الذي وقع الخلاف فيه فهناك يجب على المعلل الأشتغال بالترجيح
وعن الثاني أنا بينا أن مجرد المقارنة دليل العلية ظاهرا فلم يكن القول به مجرد التشهي
الفصل التاسع في تنقيح المناط
قال الغزالى رحمه الله إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون باستخراج الجامع
وقد يكون بإلغاء الفارق وهو أن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذا وذلك لا تأثير له في الحكم ألبتة فيلزم اشتراك الفرع والأصل في ذلك الحكم
وهذا هو الذي يسميه أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بالاستدلال ويفرقون بينه وبين القياس
وأعلم أن هذا لا يمكن ايراده على وجهين
الأول أن يقال هذا الحكم لابد له من مؤثر وذلك المؤثر إما القدر المشترك بين الأصل والفرع أو القدر الذي أمتاز به الأصل عن الفرع والثاني باطل لأن الفارق ملغى فثبت أن المشترك هو العلة فيلزم من حصوله في الفرع ثبوت الحكم
فهذا طريق جيد إلا أنه استخراج العلة بطريق السبر لأنا قلنا حكم الأصل لابد له من علة وهى إما جهة الاشتراك أو جهة الامتياز
والثاني باطل فتعين الأول وجهة الاشتراك حاصلة في الفرع فعلة الحكم حاصلة في الفرع فيلزم تحقق الحكم في الفرع
فهذا هو طريقة السبر والتقسيم من غير تفاوت أصلا
وثانيهما أن يقال هذا الحكم لابد له من محل ولا يمكن أن يكون ما
به الامتياز جزءا من محل هذا الحكم فالمحل هو القدر المشترك فإذا كان ذلك المحل حاصلا في الفرع وجب ثبوت الحكم فيه مثل أن يقال ما به امتاز الإفطار بالأكل عن الإفطار بالوقاع ملغى فمحل الحكم هو المفطر فأينما حصل المفطر وجب حصول الحكم
وهذا الوجه ضعيف لأنه لا يلزم من ثبوت الحكم في المفطر ثبوته في كل مفطر فإنه إذا صدق أن هذا الرجل طويل صدق أن الرجل طويل لأن الرجل جزء من هذا الرجل ومتى حصل المركب حصل المفرد ثم لم يلزم من صدق قولنا الرجل طويل قولنا كل رجل طويل فكذا هاهنا
الفصل العاشر في الطرق الفاسدة وهو طريقان
الأول قال بعضهم الدليل على أن هذا الوصف علة عجز الخصم افساده وهو ضعيف لأنه ليس جعل العجر عن الإفساد دليلا على الصحة أولى من جعل العجز عن التصحيح دليلا على الفساد بل هذا أولى لأنا لو أثبتنا كل مالا نعرف دليلا على فساده لزمنا إثبات مالا نهاية له وهو باطلأما لو لم نثبت كل مالا نعرف دليلا على صحته لزمنا أن لا نثبت مالا نهاية له وهو حق
الثاني قال بعضهم هذا الذي ذكرته عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع فوجب دخوله تحت قوله تعالى فاعتبروا
وربما قيل هذا تسوية بين الأصل والفرع فيكون فيكون مأمورا به لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل
وهذا ضعيف أيضا لأن أقصى ما في الباب عموم اللفظ في هاتين الآيتين وتخصيص العموم بالإجماع جائز
وأجمع السلف على أنه لا بد من دلالة ما على تعين الوصف للعلية وللمخالف أن ينكر هذا الإجماع
الباب الثاني في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة وهي خمسة النقض
وعدم التأثير والقلب والقول بالموجب والفرق
الفصل الأول في النقض وفيه مسائل
المسألة الأولى وجود الوصف مع عدم الحكم يقدح في كونه علة وزعم الأكثرون أن علية الوصف إذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في عليتهوزعم آخرون أن علية الوصف و إن ثبتت بالمناسبة أو الدوران لكن إذا كان تخلف الحكم عنه لمانع لم يقدح في عليته
أما إذا كان التخلف لا لمانع فالأكثرون على أنه يقدح في العلية ومنهم من قال لا يقدح أيضا
لنا وجوه
الأول أن اقتضاء العلة للحكم إما أن يعتبر فيه انتفاء المعارض أو لا يعتبرفإن اعتبر لم يكن علة إلا عند انتفاء المعارض وهذا يقتضي أن الحاصل قبل انتفاء المعارض ليس تمام العلة بل بعضها
وإن لم يعتبر فسواء حصل المعارض أو لم يحصل كان الحكم حاصلا وذلك يقدح في كون المعارض معارضا
فإن قيل لم لا يجوز أن يتوقف الاقتضاء على انتفاء المعارض
قوله هذا يدل على أن الحاصل قبل انتفاء المعارض ما كان تمام العلة بل جزءا منها
قلنا لا نسلم ولم لا يجوز أن يكون هذا العدم شرطا لتأثير العلة في الحكم
تقريره العلة إما أن تفسر بالداعي أو المؤثر أو المعرف
أما المؤثر فإما أن يكون قادرا أو موجبا
أما القادر فيجوز أن يتوقف صحة تأثيره على انتفاء المعارض لأمور
الأول أن الفعل في الأزل محال لأن الفعل ماله أول والأزل مالا أول له والجمع بينهما محال
فإذن تتوقف صحة تأثير قدرة الله تعالى في الفعل على نفى الأزل فالقيد العدمي لا يجوز أن يكون جزءا من المؤثرات الحقيقية فهو إذن شرط صحة التأثير
وثانيها أن إشالة القادر الثقيل إلى فوق يقتضى الصعود إلى فوق بشرط أن لا يجره قادر أخر إلى أسفل فالقيد العدمي لا يكون جزءا من المؤثر الحقيقي
وثالثها أن القادر لا يصح منه خلق السواد في المحل إلا بشرط عدم البياض فيه والعدم لا يكوم جزءا من المؤثر الحقيقي
أما الموجب فهو أن الثقل يوجب الهوى بشرط عدم المانع وسلامة الحاسة توجب الإدراك بشرط عدم الحجاب
وأما الداعي فمن أعطى إنسانا لفقره فجاء أخر فقال لا أعطيه لأنه يهودى فعدم كون الأول يهوديا لم يكن جزءا من المقتضى في إعطاء الأول لأنه حين أعطى الفقير الأول لم تكن اليهودية خاطرة بباله فضلا عن عدمها ومالا يكون خاطرا بالبال لم يكن جزءا من الداعي فعلمنا أن عدم كون الأول يهوديا لم يكن جزءا من المقتضى
أما المعرف فالعام المخصوص دليل على الحكم وعدم المخصص ليس جزءا من المعرف وإلا كان يجب ذكره عند الاستدلال
فثبت بما ذكرنا أن عدم المعارض وإن كان معتبرا لكنه ليس جزءا من العلة
سلمنا كونه جزءا ولكن يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى بحث لفظي لا فائدة فيه لأن من جوز تخصيص العلة ومن لم
يجوزه اتفقوا على أن اقتضاء العلة للحكم لابد فيه من ذلك العدم وأنتم أيضا سلمتم أن المعلل لو ذكر ذلك القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة فلم يبق الخلاف إلا في أن ذلك القيد العدمى هل يسمى جزء العلة أم لا ومعلوم أن ذلك مما لا فائدة فيه
والجواب
قد بينا أنه لو توقف اقتضاء العلة للحكم على انتفاء المعارض لم يكن الحاصل عند وجود المعارض تمام العلة بل جزءهاقوله لو كان كذلك لزم جعل القيد العدمي جزءا من علة الوجود
قلنا إن فسرنا العلة بالموجب أو الداعي امتنع جعل القيد العدمي جزءا من علة الوجود
فحينئذ لا نقول إن عدم المعارض جزء العلة بل نقول إنه يدل على أنه حدث أمر وجودى انضم إلى ما كان موجودا قبل
وحينئذ صار ذلك المجموع علة تامة فلم يلزم من قولنا العلة التامة إنما وجدت حال عدم المعارض أن يجعل عدم المعارض جزءا من العلة
وإن فسرنا العلة بالمعرف لم يمتنع جعل القيد العدمي جزءا من العلة بهذا التفسير كما أنا نجعل انتفاء المعارض جزءا من دلالة المعجز على الصدق
قوله لو كان عدم المخصص جزءا من المعرف لوجب على المتمسك بالعام المخصوص ذكر عدم المخصصات
قلنا لا شك أنه لا يجوز التمسك بالعام إلا بعد ظن عدم المخصصات فأما أنه لم يجب الذكر في الابتداء فذلك يتعلق بأوضاع أهل الجدل والتمسك بها في إثبات الحقائق غير جائز
قوله إنه يصير الخلاف لفظيا
قلنا لا نسلم فإنا إذا فسرنا العلة بالداعي أو الموجب لم نجعل العدم جزءا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة ومن يجوز التخصيص لا يقول بذلك
وإن فسرناها بالأمارة ظهر الخلاف في المعنى أيضا لأن من أثبت العلة بالمناسبة بحث عن ذلك القيد العدمي فإن وجد فيه مناسبة صحح العلة وإلا أبطلها
ومن يجوز التخصيص لا يطلب المناسبة ألبتة من هذا القيد العدمي
الحجة الثانية في المسألة
أنه لا بد وأن بين كون المقتضى مقتضيا اقتضاء حقيقيا بالفعل وبين كون المانع مانعا منعا حقيقيا بالفعل منافاة بالذات وشرط طريان أحد الضدين انتقاء الضد الأول فلا يجوز أن يكون انتفاء الأول لطريان اللاحق وإلا وقع الدور فلما كان شرط كون المانع مانعا خروج المقتضى عن أن يكون مقتضيا بالفعل لم يجز أن يكون خروجه عن كونه مقتضيا بالفعل لأجل تحقق المانع بالفعل وإلا وقع الدرو
فإذن المقتضي إنما خرج عن كونه مقتضيا لا بالمانع بل بذاته وقد انعقد الإجماع على أن ما يكون كذلك فإنه لا يصلح للعلية
الحجة الثالثة الوصف وجد في الأصل مع وجود الحكم وفي صورة التخصيص مع عدم الحكم ووجوده مع الحكم لا يقتضى القطع بكونه علة لذلك الحكم لكن وجوده مع عدم الحكم في صورة التخصيص يقتضى القطع بأنه ليس بعلة لذلك الحكم
ثم أن الوصف الحاصل في الفرع كما أنه مثل الوصف الحاصل في الأصل فهو أيضا مثل الوصف الحاصل في صورة
التخصيص فليس إلحاقه بأحدهما أولى ما إلحاقه بالآخر ولما تعارضا لم يجز إلحاقه بواحد منهما فلم يجز الحكم عليه بالعلية
قال المجوزون الأصل في الوصف المناسب مع الاقتران أن يكون علة فعند ذلك إذا رأينا الحكم متخلفا عنه في صورة وعثرنا في تلك الصورة على أمر يصلح أن يكون مانعا وجب إحالة ذلك التخلف على ذلك المانع عملا بذلك الأصل
أجاب المانعون بأن الأصل ترتب الحكم على المقتضي فحيث لم يترتب الحكم عليه وجب الحكم بأنه ليس بعلة عملا بهذا الأصل فصار هذا الأصل معارضا للأصل الذي ذكرتموه وإذا تعارضا وجب الرجوع إلى ما كان عليه أولا وهو عدم العلية
قال المجوزون الترجيح معنا من وجهين
الأول أنا لو اعتقدنا أن هذا الوصف غير مؤثر يلزمنا ترك العمل بالمناسبة مع الاقتران من كل وجه
ولو اعتقدنا أنه مؤثر عملنا بما ذكرتم من الدليل من بعض الوجوه لأن ذلك الوصف يفيد الأثر في بعض الصور ولا شك أن ترك العمل بالدليل من وجه أولى من ترك العمل بالدليل من كل الوجوه
الثاني هو أن الوصف الذي ندعى كونه مانعا في صورة التخصيص يناسب انتفاء الحكم والانتفاء حاصل معه فيغلب على الظن أن المؤثر في ذلك الانتفاء هو ذلك المانع وإذا ثبت استناد ذلك الإنتفاء إلى المانع امتنع استناده إلى عدم المقتضى
إذا ثبت هذا فنقول معكم أصل واحد وهو أن الأصل ترتب الحكم على العلة ومعنا أصلان
أحدهما أن المناسبة مع الاقتران دليل على كون الوصف في الأصل علة لثبوت الحكم فيه
الثاني أن المناسبة مع الاقتران في صورة التخصيص دليل على كون المانع علة لانتفاء الحكم فيها ومعلوم أن العمل بالأصلين أولى من العمل بالأصل الواحد
أجاب المانعون عن الأول بأنا لا نسلم أن المناسبة مع الاقتران دليل العلية بل عندنا المناسبة مع الاقتران والاطراد دليل العلية فإن حذفتم الاطراد عن درجة الاعتبار فهو أول المسألة
وعن الثاني أنا لا نسلم أن انتفاء الحكم في محل التخصيص يمكن تعليله بالمانع لأن ذلك الانتفاء كان حاصلا قبل حصول ذلك المانع والحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا
أجاب المثبتون عن هذا من وجهين
الأول أن العلل الشرعية معرفات فلا يمتنع كون المتأخر علة للمتقدم بهذا التفسيرالثاني أن المانع علة لنفى الحكم لا لانتفائه والنفى عبارة عن منعه من الدخول في الوجود بعد كونه بعرضية الدخول
أجاب المانعون عن الأول بأنه إذا كان المراد من العلة المعرف لم يلزم من تعليل ذلك الانتفاء بعدم المقتضى تعذر تعليله أيضا بالمانع لجواز أن يدل على المدلول الواحد دليلان أحدهما وجودى والآخر عدمى
وعن الثاني أن تأثير المانع ليس في إعدام شيء لأن ذلك يستدعى سابقة الوجود وهاهنا الحكم لم يوجد ألبتة فيمتنع إعدامه فعلم
أن المستند إلى المانع ليس إلا ذلك العدم السابق
احتج من جوز تخصيص العلة بوجوه
أحدها أن دلالة العلة على ثبوت الحكم في محالها كدلالة العام على جميع الأفراد وكما أن تخصيص العام لا يوجب خروج العام عن كونه حجة فكذا تخصيص العلة لا يقدح في كونها علةوثانيها أن اقتضاء الوصف لذلك الحكم في هذا المحل إما أن يتوقف على اقتضاء الحكم في ذلك المحل الآخر أو لا يتوقف
والأول محال لأنه ليس توقف أحدهما على الآخر أولى من
العكس فيلزم افتقار كل واحد منهما إلى الآخر فيلزم الدور
وإن لم يفتقر واحد منهما إلى الآخر فحينئذ لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر فلا يلزم من انتفاء كون الوصف مقتضيا لذلك الحكم في هذا المحل انتفاء كونه مقتضيا لذلك الحكم في المحل الآخر
وثالثها العقلاء اجمعوا على جواز ترك العمل بمقتضى الدليل في بعض الصور لقيام دليل أقوى من الأول فيه مع أنه يجوز التمسك بالأول عند عدم المعارض فإن الإنسان يلبس الثوب لدفع الحر والبرد وإذا اتفق لبعض الناس أن قال له ظالم إن لبست هذا الثوب قتلتك فإنه يترك العمل بمقتضى الدليل الأول في هذه الصورة وإن كان يعمل بمقتضاه في غيرها من الصور
وإذا ثبت حسن ذلك في العادة وجب حسنه في الشرع لقوله عليه الصلاة و السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
ورابعها أن العلة الشرعية أمارة فوجودها في بعض الصور دون حكمها لا يخرجها عن كونها أمارة لأنه ليس من شرط كون الشيء أمارة على الحكم أن يستلزمه دائما فإن الغيم الرطب في الشتاء أمارة المطر ثم عدم المطر في بعض الأوقات لا يقدح في كونه أمارة
وخامسها أن الوصف المناسب بعد التخصيص يقتضى ظن ثبوت الحكم فوجب العمل به
بيان الأول أنا إذا عرفنا من الإنسان كونه مشرفا مكرما مطلوب البقاء غلب على ظننا حرمة قتله وإن لم يخطر ببالنا في ذلك الوقت ماهية
الجناية فضلا عن عدمها فعلمنا أن مجرد النظر إلى الإنسانية مع مالها من الشرف يفيد ظن حرمة القتل وأن عدم كونه جانيا ليس جزءا من المقتضى لهذا الظن
وإذا كان كذلك فأينما حصلت الإنسانية حصل ظن حرمة القتل
وإذا ثبت أنه يفيد ظن الحكم وجب العمل به لأن العمل بالظن واجب
وسادسها أن بعض الصحابة قال بتخصيص العلة روى عن ابن مسعود أنه كان يقول هذا حكم معدول به عن القياس وعن ابن عباس مثله ولم ينقل عن أحد أنه أنكر ذلك عليهما وذلك يفيد انعقاد الإجماع
وسابعها أنه وجد في الأصل المناسبة مع الاقتران في ثبوت الحكم
وفي صورة التخصيص المناسبة مع الاقتران في انتفاء الحكم فلو أضفنا في صورة التخصيص انتفاء الحكم إلى انتفاء المقتضى كنا قد تركنا العمل بذينك الأصلين لكنا عملنا بأصل واحد وهو أن الأصل أن يكون عدم الحكم لعدم المقتضى
أما لو أضفنا في صورة التخصيص انتفاء الحكم إلى حصول المانع كنا عملنا بذينك الأصلين وخالفنا أصلا واحدا وهو أن يكون عدم الحكم لعدم المقتضي ومعلوم أن مخالفة الأصل الواحد لإبقاء أصلين أولى من العكس فإحالة انتفاء الحكم على المانع أولى من إحالته على عدم المقتضى
والجواب عن الأول أن نقول ما الجامع
ثم الفرق أن دلالة العام المخصوص على الحكم وإن كانت موقوفة على عدم المخصص إلا أن عدم المخصص إذا ضم إلى العام صار المجموع دليلا على الحكم أما العلة فإن دلالتها موقوفة على عدم المخصص وذلك العدم لا يجوز ضمه إلى العلة على جميع التقديرات
أما أولا فلأن منهم من منع كون القيد العدمى جزءا من علة الحكم الوجودى
والذين جوزوه قالوا إنما يجوز ذلك بشرط أن يكون مناسبا فلا جرم وجب ذكره في أول الأمر ليعرف أنه هل يصلح لأن يكون جزءا لعلة الحكم أم لا
وعن الثاني أنا إن فسرنا العلة بالموجب أو الداعي كان شرط كونه علة للحكم في محل أن يكون علة لذلك الحكم في جميع المحال لأن العلة إنما توجب الحكم لماهيتها ومقتضى الماهية أمر واحد فإن كانت تلك الماهية موجبة لذلك الحكم في موضع وجب كونها كذلك في كل المواضع وإلا فلا
وعن الثالث أنه لا نزاع فيما قالوه لكنا ندعي أنه ينعطف من الفرق بين
الأصل وبين صورة التخصيص قيد على العلة وهم ما أقاموا الدلالة على فساد ذلك
وعن الرابع أن النظر في الأمارة إنما يفيد ظن الحكم إذا غلب على الظن انتفاء ما يلازمه انتفاء الحكم فإن من رأى الغيم الرطب في الشتاء بدون المطر في بعض الأوقات ثم رآه مرة أخرى فإنه لا يغلب على ظنه نزول المطر إلا إذا غلب على ظنه انتفاء الأمر الذي لازمه عدم نزول المطر في المرة الأولى وذلك لا يقدح في قولنا
وعن الخامس أنه مسلم لكنا ندعى أنه ينعطف من الفرق بين الأصل وصورة التخصيص قيد على العلة
وعن السادس هب أنهم قالوا ذلك لكنهم لم يقولوا التمسك بذلك القياس جائز أم لا
وعن السابع ما ذكرناه في الحجة الثالثة من جانبنا
المسألة الثانية في كيفية دفع النقض هذا لا يمكن إلا بأحد أمرين
أحدها المنع من حصول تمام تلك الأوصاف في صورة النقضوالثاني المنع من عدم الحكم
أما القسم الأول ففيه أبحاث
أحدها المستدل إذا منع من وجود الوصف في صورة النقض لم يمكن المعترض من إقامة الدليل على وجوده فيها لأنه انتقال إلى مسألة أخرى بلى لو قال المعترض ما دللت به على وجود المعنى في الفرع يقتضى وجوده في صورة النقض فهذا لو صح لكان نقضا على دليل وجود العلة في الفرع لا على كون ذلك الوصف علة للحكم فيكون انتقالا من السؤال الذي بدأ به إلى غيره
وثانيها أن المنع من وجود الوصف في صورة النقض إنما يمكن لو وجد قيد في العلة يدفع النقض وذلك القيد إما أن يكون له معنى واحد أو معنيان فإن كان معناه واحدا فإما أن يكون وقوع الاحتراز به ظاهرا أو لا يكون
مثال الظاهر قولنا طهارة عن حدث فتفتقر إلى النية كالتيمم فنقضه بإزالة النجاسة غير وارد لأنا نقول عن حدث وإزالة النجاسة لا تكون عن حدث
مثال الخفي قولنا في السلم الحال عقد معاوضة فلا يكون الأجل من شرطه كالبيع ولا ينتقض بالكتابة لأنها ليست معاوضة لكنها عقد إرفاق
أما إذا كان اللفظ له معنيان فإما أن يكون مقولا عليهما بالتواطؤ أو بالاشتراك
مثال التواطؤ قولنا عبادة متكررة فتفتقر إلى تعيين النية كالصلاة
فإن قيل ينتقض بالحج فإنه يتكرر على زيد وعمرو
قلنا التكرار مقول على التكرار في الزمان وعلى التكرار في الأشخاص والأظهر هو الأول وهو مرادنا هاهنا
مثال الاشتراك قولنا جمع الطلاق في القرء الواحد لا يكون مبتدعا كما لو طلقها ثلاثا في قرء واحد مع الرجعة بين الطلقتين
فإن قيل ينتقض بما لو طلقها في الحيض
قلنا أردنا بالقرء الطهر
وثالثها أنه هل يجوز دفع النقض بقيد طردي أما الطاردون فقد جوزوه
وأما منكرو الطرد فمنهم من جوزه
والحق أن لا يجوز لأن أحد أجزاء العلة إذا لم يكن مؤثرا لم يكن مجموع العلة مؤثرا ولأنه لو جاز تقيده بالقيد الطردي لجاز تقييده بنعيق الغراب وصرير الباب وبالشخص والوقت ولا نزاع في فساده
القسم الثاني في منع عدم الحكم وفيه أبحاث
أحدها أن انتفاء الحكم إن كان مذهبا للمعلل والمعترض معا كان متوجهاوإن كان مذهبا للمعلل فقط كان متوجها أيضا لأن المعلل إذا لم يف بمقتضى علته في الإطراد فلأن لا يجب على غيره كان أولى
وإن كان مذهبا للمعترض فقط لم يتوجه لأن خلاف المعترض في تلك المسألة كخلافه في المسألة الأولى وهو محجوج بذلك الدليل في المسألتين معا
وثانيها أن المنع من عدم الحكم قد يكون ظاهرا وهو معلوم
وقد يكون خفيا وهو على وجهين
الأول كقولنا في السلم الحال عقد معاوضة فلا يكون الأجل من شرطه فإن قيل ينتقض بالإجارة
قلنا الأجل ليس شرطا في الإجارة بل تقدير المعقود عليه
الثاني كقولنا عقد معاوضة فلا ينفسخ بالموت كالبيع
فإن قيل ينتقض بالنكاح
قلنا هناك لا ينتقض بالموت لكن انتهى العقد
وثالثها أن الحكم إما أن يكون مجملا أو مفصلا وكل واحد منهما إما في طرف الثبوت أو في طرف الانتفاء
فهذه الأقسام أربعة
الأول الإثبات المجمل والمراد أنا ندعي بثبوته ولو في صورة ما فهذا لا ينتقض بالنفي المفصل وهو النفي عن صورة معينة لأن الثبوت المجمل يكفي فيه ثبوته في صورة واحدة والثبوت في صورة واحدة لا يناقضه النفي في صورة معينة
الثاني النفي المجمل ومعناه أنه لا يثبت ألبتة ولا في صورة واحدة فهذا ينتقض بالثبوت المفصل لأن ادعاء النفي عن كل الصور يناقضه في صورة معينة
الثالث الإثبات المفصل لا يناقضه النفي المفصل لأن الثبوت في صورة معينة لا يناقضه النفي في صورة أخرى لكن يناقضه النفي المجمل لأن الثبوت في صورة واحدة يناقضه النفي المجمل
الرابع النفي المفصل لا يناقضه الإثبات المفصل لما تقدم ولا الإثبات المجمل لأنه في قوة الإثبات المفصل بل يناقضه الإثبات العام
ورابعها أن الحكم الذي لا يكون ثابتا تحقيقيا لكنه يكون ثابتا تقديرا هل يكون ذلك دافعا للنقض
مثاله إذا قال ملك الأم علة لرق الولد
قيل ينتقض ذلك بولد المغرور بحرية الجارية فإنه ينعقد ولده حرا فهاهنا انتفى ملك الولد تحقيقا ولكنه موجودا تقديرا بدليل أن الغرم يجب على المغرور ولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع وإلا لما وجبت قيمة الولد
المسألة الثانية وهي مشتملة على فرعين من فروع تخصيص العلة
الفرع الأول إذا تخلف الحكم عن العلة لا لمانع فهل يقدح ذلك في صحة العلة أم لا قال قوم لا يقدح لأنا لم ندع في مثل هذه العلة كونها مستلزمة للحكم قطعا بل ادعينا كونها مستلزمة للحكم ظاهرا فتخلف الحكم عنها في بعض الصور لا يقدح في كونها مستلزمة له غالبا فوجب أن لا يكون مفسدا للعلة
والحق أنه مفسد للعلة لأن ذات العلة إما أن تكون مستلزمة للحكم أو لا تكون
فإن كانت مستلزمة له وجب كونها كذلك أبدا ولو كانت كذلك أبدا لما زال هذا الحكم إلا لمزيل وذلك المزيل هو المانع فحيث زالت تلك المستلزمية لا لمزيل علمنا أن تلك الذات غير موصوفة بتلك المستلزمية فوجب أن لا يكون علة
الفرع الثاني المتمسك بالعلة المخصوصة هل يجب عليه في ابتداء الدليل ذكر نفي المانع أم لا
أما الذين قالوا لا يجب ذكره في الابتداء قالوا لأن المستدل مطالب بذكر ما يكون موجبا للحكم ومؤثرا فيه والموجب لذلك الحكم هو ذلك الوصف
وأما نفي المانع فليس له دخل في التأثير وإذا كان كذلك لم يجب ذكره في الابتداء
والذين قالوا يجب احتجوا بأن المستدل مطالب بذكر ما يكون معرفا للحكم والمعرف للحكم ليس تلك الأمارة فقط بل تلك الأمارة مع عدم المخصص
وإذا كان كذلك وجب ذكرهما معا فمقتضى هذا الدليل بيان نفي كل الموانع ابتداءا إلا أن إيجاب ذلك يفضي إلى العسر والمشقة
أما إيجاب نفي الموانع المتفق عليها فلا يفضي إلى ذلك فوجب أن يجب ذكره
المسألة الرابعة
في أن النقض إذا كان واردا على سبيل الاستثناء هل يقدح في العلة أم لاقال قوم إنه لا يقدح سواء كانت العلة معلومة أو مظنونة
أما المعلومة فلأنا نعلم أن من لم يقدم على جناية لا يؤاخذ بضمانها ثم هذا لا ينتقض بضرب الدية على العاقلة
وأما المظنونة فكاالتعليل بالطعم فإنه لا ينتقض بمسألة العرايا فإنها وردت على سبيل الاستثناء رخصة
واعلم أنا إنما نعلم ورود النقض على سبيل الاستثناء إذا كان لازما على جميع المذاهب مثل مسألة العرايا فإنها لازمة على جميع العلل كالقوت والكيل والمال والطعم
وإنما قلنا أن الوارد مورد الاستثناء لا يقدح في العلة لأن
الإجماع لما انعقد على أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة ومسألة العرايا ورادة عليها أربعتها فكانت هذه المسألة واردة على علة قطعنا بصحتها والنقض لا يقدح في مثل هذه العلة
وأما أنه هل يجب الاحتراز عنه في اللفظ فقد اختلفوا فيه والأولى الاحتراز منه
المسألة الخامسة
الكسر نقض يرد على المعنى دون اللفظ كما إذا قال في وجوب صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها قياسا على صلاة الأمن فيظن المعترض أنه لا تأثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم وأن المؤثر هو وجوب القضاء فينقضه بصوم الحائض فإنه يجب قضاؤه ولا يجب أداؤهوأعلم أن المعترض ما لم يبين إلغاء القيد الذي به وقع الاحتراز عن النقض لا يمكنه إيراد النقض على الباقي فيكون ذلك في الحقيقة قدحا في تمام العلة لعدم التأثير في جزءها بالنقض
الفصل الثاني في عدم التأثير
وهو عبارة عما إذا كان الحكم يبقى بدون ما فرض علة لهوأما العكس فهو أن يحصل مثل هذا الحكم في صورة أخرى لعلة تخالف العلة الأولى
وإذا عرق هذا فنقول
الدليل على أن عدم التأثير يقدح في كون الوصف علة هو أن الحكم لما بقى بعد عدمه وكان موجودا قبل وجوده علمنا استغناءه عنه والمستغنى عن الشيء لا يكون معللا بهواعلم أن هذا حق إذا فسرنا العلة بالمؤثر
أما إذا فسرناها بالمعرف فلا لجواز أن كون الحادث معرفا لوجود ما كان موجودا قبله ويبقى موجودا بعده كالعالم مع البارى تعالى
وأما أن العكس غير واجب في العلل فهو قولنا وقول المعتزلة
وأما أصحابنا فإنهم أوجبوا العكس في العلل العقلية وما أوجبوا في العلل الشرعية
والدليل على عدم وجوبه في العلل العقلية أن المختلفين يشتركان في كون كل واحد منهما مخالفا للأخر وتلك المخالفة من لوازم ماهيتهما واشتراك اللوازم مع اختلاف الملزومات يدل على قولنا
والذي يدل على جواز ذلك في العلل الشرعية أنا سنقيم الدلالة على جواز تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة في الشرعيات وذلك يوجب القطع بأن العكس غير معتبر
الفصل الثالث في القلب وفيه مسائل
المسألة الأولى في حقيقتهوحقيقتة أن يعلق على العلة المذكورة في قياس نقيض الحكم المذكور فيه ويرد إلى ذلك الأصل بعينه
وإنما شرطنا إتحاد الأصل لأنه لو رد إلى أصل آخر لكان ذلك الأصل الآخر إما أن يكون حاصلا في الأصل الأول أو لا يكون
فإن كان الأول كان رده إليه أولى لأن المستدل لا يمكنه منع وجود تلك العلة فيه ويمكنه منع وجودها في أصل آخر
وإن كان الثاني كان أصل القياس الآخر نقضا على تلك العلة لأن ذلك الوصف حاصل فيه مع عدم ذلك الحكم
المسألة الثانية منهم من أنكر إمكانه لوجهين
الأول أن الحكم الذي علقه القالب على العلة لابد وأن يكون مخالفا للحكم الذي علقه القائس عليها وإلا لما كان إلا تكريرا في اللفظثم إن ذينك الحكمين إما أن يمكن اجتماعهما أو لا يمكن
فإن كان الأول لم يقدح ذلك في العلة لأنه لا امتناع في أن يكون للعلة الواحدة حكمان غير متنافيين
والثاني محال لأنا بينا أن الأصل الذي يرد إليه القالب والقائس لابد وأن يكون واحدا والصورة الواحدة يستحيل أن يحصل فيها حكمان متنافيان
الثاني أن العلة المستنبطة لابد وأن تكون مناسبة للحكم والوصف الواحد يستحيل أن يكون مناسبا لحكمين متنافيين
والجواب عن الأول أن هاهنا احتمالا آخر وهو أن لا يكون الحكمان متنافيين فلا جرم يصح حصولهما في الأصل لكن دل دليل منفصل على امتناع اجتماعهما في الفرع فإذا بين القالب أن الوصف الحاصل في الفرع ليس بأن يقتضى أحد الحكمين أولى من الآخر
كان الأصل شاهدا لهما بالاعتبار لما بينا أنه لا منافاة بينهما في الأصل
ويقتضى امتناع حصول الحكم في الفرع لما أنه ليس حصول أحدهما أولى من الآخر وقد قامت الدلالة على امتناع حصولهما في الفرع
وهذا الكلام كما أنه جواب عن شبهة المنكر فهو دليل إبتداءا على إمكان القلب
وعن الثاني أن المناسبة قد لا تكون حقيقية بل إقناعية فبالقلب ينكشف أنها ما كانت حقيقية
المسألة الثالثة القلب معارضة إلا في أمرين
أحدهما أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي سائر المعارضات يمكن
الثاني أنه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والأصل لأن أصله وفرعه هو أصل المعلل وفرعه ويمكن ذلك في سائر المعارضات
وأما فيما وراء هذين الوجهين فلا فرق بينه وبين المعارضة
فعلى هذا للمستدل أن يمنع حكم القالب في الأصل وأن يقدح في تأثير العلة فيه بالنقض وعدم التأثير وأن يقول بموجبه إذا أمكنه بيان أن اللازم من ذلك القلب لا ينافي حكمه وأن يقلب قلبه إذا لم يكن قلب القالب مناقضا للحكم لأن قلب القالب إذا فسد بالقلب الثاني سلم أصل القياس من القلب
المسألة الرابعة
القالب إما أن يذكر القلب لإثبات مذهبه أو لإبطال مذهب خصمه والأول مثل أن يقول الحنفي في أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بدون الصوم قربة كالوقوف بعرفة فيقول القالب لبث مخصوص فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة فالحكمان المذكوران في الأصل والقلب لا يتنافيان في الأصل ويتنافيان في الفرع
وأما الثاني فإما أن يدل القالب على فساد مذهبه صريحا أو ضمنا وهو أن يدل على فساد لازم من لوازم مذهب الخصم
مثال الأول قول الحنفي في المسح ركن من أركان الوضوء فلا يكتفى فيه بأقل ما يقع عليه الاسم كالوجه فيقول القالب فوجب أن لا يتقدر الفرض فيه بالربع كالوجه وهذان الحكمان لا يتناقضان في ذاتيهما لأنهما حصلا في الوجه ولكن يتنافيان في الفرع بواسطة اتفاق الإمامين
مثال الثاني قولهم في بيع الغائب عقد معاوضة فيعقد مع الجهل بالعوض كالنكاح
فيقول القالب فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح ويلزم من فساد خيار الرؤية فساد البيع وهذان الحكمان غير متنافيين في الأصل لأنه اجتمع في النكاح الصحة وعدم الخيار لكن لا يمكن اجتماعهما في الفرع
وقال بعضهم هذا النوع من القلب غير مقبول لأن دلالة الوصف على ثبوت الحكم لا بواسطة أظهر من دلالته على انتفاء الحكم بواسطة
وأعلم أنه يقع في هذا النوع شيء يسمى قلب التسوية مثاله أن يقول الحنفي في طلاق المكره مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه كالمختار فيقول القالب فوجب أن يستوى حكم إيقاعه وإقراره كالمختار
وبعضهم قدح فيه بأن قال الحاصل اعتبارهما معا في
الثبوت في الأصل وفي الفرع عند القالب عدم وقوعهما معا فكيف تتحقق التسوية
جوابه أن عدم الاختلاف بين الحكمين حاصل في الفرع والأصل لكن في الفرع في جانب العدم وفي الأصل في جانب الثبوت وذلك لا يقدح في الاستواء في الأصل
الفصل الرابع في القول بالموجب
وحده تسليم ما جعله المستدل موجب العلة مع استبقاء الخلاف وهو يقع في جانب النفي على وجهوفي جانب الإثبات على وجه أخر
أما في جانب النفي فإذا كان المطلوب نفى الحكم واللازم من دليل المعلل كون شيء معين غير موجب لذلك الحكم كما لو قال الشافعى في المثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه فيقول السائل إن التفاوت
في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص فلم لا يمتنع وجوب القصاص بسبب آخر
ثم أن المستدل لو بين بعد ذلك أنه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم محل النزاع كان منقطعا أيضا لأنه ظهر أنه ما ذكر الدليل بل ذكر أحد أجزاء الدليل
وأما جانب الثبوت فكما لو كان المطلوب إثبات الحكم في الفرع واللازم من دليل المعلل ثبوته في صورة ما من الجنس كما لو قال في وجوب الزكاة في الخيل حيوان تجوز المسابقة عليه فيجب فيه الزكاة قياسا على الإبل فقال أقول بموجبه إنه تجب فيه زكاة التجارة والخلاف واتقع في زكاة العين ومقتضى دليلك وجوب أصل الزكاة
الفصل الخامس في الفرق
والكلام فيه مبنى على أن تعليل الحكم الواحد بعلتين هل يجوز أم لا وفيه مسألتانالمسألة الأولى
يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافا لبعضهملنا أن الردة والقتل والزنا كل واحد منها لو انفرد كان
مستقلا باقتضاء حل القتل ثم إنه يصح اجتماعها فعند اجتماعها يكون حل الدم حاصلا بها جميعا
فإن قيل لا نسلم أن هناك حكما واحدا بل أحكاما كثيرة فإن حل القتل بسبب الردة غير حله بسبب القتل والدليل عليه وجهان
الأول أن الرجل إذا عاد إلى الإسلام زالت الإباحة الحاصلة بسبب الردة وبقيت الإباحة الحاصلة بسبب القتل والزنا
ثم إذا عفا ولى الدم زالت الإباحة الحاصلة بسبب القتل وبقيت الإباحة الحاصلة بسبب الزنا
الثاني أن القتل المستحق بسبب القتل يجوز العفو عنه لولى الدم والقتل المستحق بسبب الردة لا يتمكن الولى من إسقاطه وذلك يدل على تغاير الحكمين
سلمنا أن الحكم واحد ولكن لا نسلم أنه يمكن حصول هذه الأسباب الثلاثة دفعة واحدة ولم لا يجوز أن يقال لابد وأن يحصل منها واحد قبل حصول البواقي
وحينئذ يكون الحكم محالا على السابق
سلمنا إمكان حصولها دفعة واحدة لكن لم لا يجوز أن يقال إنها بأسرها مشتركة في وصف واحد والعلة هو ذلك المشترك فتكون علة الحكم شيئا واحدا
سلمنا أنه ليس هناك قدر مشترك لكن لم لا يجوز أن يقال شرط كون كل واحد منها علة مستقلة انتفاء الغير فإذا وجد الغير زال شرط الاستقلال بالعلية
فحينئذ لا يكون كل واحد منها علة تامة عند الاجتماع بل يصير كل واحد منها عند الاجتماع جزء العلة والمجموع هو العلة التامة
سلمنا أن ما ذكرته يدل على تعليل الحكم الواحد بعلتين لكن معنا ما يمنع منه وهو وجوه ثلاثة
الأول أن جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين يفضى إلى نقض العلة وذلك باطل على ما مر فما أفضى إليه مثله
بيان الملازمة أنه إذا كان للحكم الواحد علل كثيرة فإذا وجد منها واحدة
حتى حصل الحكم ثم وجدت العلة الثانية بعد ذلك فهذه الثانية إما أن توجب حكما يماثل الحكم الأول أو يخالفه أو لا توجب حكما أصلا
والأول يقتضى اجتماع المثلين وهو محال
والثاني والثالث يوجب النقض لأنه وجدت تلك العلة من غير ذلك الحكم
الثاني أن العلة الشرعية مؤثرة بجعل الشرع إياها مؤثرة في ذلك الحكم فإذا اجتمع على المعلول الواحد علتان فإما أن تكون كل واحدة من العلتين مؤثرة في بعض ذلك الحكم أو في كله
والأول محال
أما أولا فلأن الحكم الواحد لا يتبعض
وأما ثانيا فلأن ذلك إخراج لكل واحدة من العلتين عن أن تكون موجبة للحكم
وأما ثالثا فلأن على هذا التقدير معلول كل واحدة منهما غير معلول الأخرى
وأما الثاني فباطل أيضا لأن الحكم لما وقع بإحدى العلتين استحال وقوعه بالأخرى
لاستحالة إيقاع الواقع
الثالث أن العلة لابد وأن تكون مناسبة للحكم فلو كانت علة لحكمين لكانت مناسبة لشيئين مختلفين فيلزم كون الشيء الواحد مساويا لمختلفين والمساوى لمختلفين مختلف فالشيء الواحد يكون مخالفا لنفسه وهو محال
والجواب قوله لا نسلم وحدة الحكم
قلنا الدليل عليه أن إبطال حياة لشخص الواحد أمر واحد وهذا الأمر الواحد إما أن يكون ممنوعا عنه من قبل الشرع بوجه ما أو لا يكون ممنوعا عنه بوجه ماوالأول هو الحرمة والثاني هو الحل
فإذا كانت الحياة واحدة كانت إزالتها أيضا واحدة فكان الإذن في تلك الإزالة واحدة
فإن قلت الفعل الواحد يجوز أن يكون حراما من وجه حلالا من
وجه وإذا كان كذلك جاز أن يتعدد الحل لتعدد جهاته فيكون الشخص الواحد مباح الدم من حيث إنه مرتد ومن حيث إنه زان ومن حيث إنه قاتل
قلت القول بأن الفعل الواحد حرام من وجه حلال من وجه غير معقول لأن الحل أن يقول الشارع مكنتك من هذا الفعل ولاتبعة عليك في فعله أصلا وهذا المعنى إنما يتحقق إذا لم يكن فيه وجه يقتضى المنع أصلا بلى ليس من شرط الحرمة أن يكون حراما من جميع جهاته لأن الظلم حرام مع أن كونه حادثا وحركة وعرضا لا يقتضى الحرمة إذا ثبت ذلك فنقول حل الدم على هذا الوجه يستحيل أن يتعدد والعلم بذلك ضروري
قوله الدليل على التغاير أنه لو أسلم زال أحد الحلين وبقى الآخر
قلنا لا نسلم أنه يزول أحد الحلين بل يزول كون ذلك الحل معللا بالردة فالزائل ليس هو نفس الحل بل وصف كونه معللا بالردة
فإن قلت إذا كان الحل باقيا سواء وجدت الردة أو زالت كان ذلك الحل غنيا في نفسه عن الردة والغنى عن الشيء لا يكون معللا به
قلت لما كانت العلة عندى عبارة عن المعرف زال عنى الإشكال
قوله ولى الدم مستقل بإسقاط أحد الحكمين
قلنا لا نسلم بل هو متمكن من إزالة أحد الأسباب فإذا زال ذلك السبب زال انتساب ذلك الحكم إلى ذلك السبب فأما أن يزول الحكم نفسه فهذا ممنوع
قوله لا نسلم جواز اجتماع هذه العلل
قلنا هذا مكابرة لأنه لا منافاة بين ذوات هذه الأمور فيصح اجتماعها ونحن نبني الكلام على تقدير وقوع ذلك الجائز
قوله العلة هي القدر المشترك بين كل هذه الأمور
قلنا هذا باطل لأن الأمة مجمعة على أن الحيض من حيث هو حيض مانع من الوطء وكذا العدة والإحرام والقول بأن العلة هى القدر المشترك مخالف لهذا الإجماع
وأما ثانيا فلأن الحيض وصف حقيقي والعدة أمر شرعي والأمر الحقيقي لا يشارك الأمر الشرعي إلا في عموم أنه أمر فلو كان هذا القدر هو العلة للمنع من الوطء لا تنتقض بالطم والرم
قوله شرط كون كل واحد منها علة مستقلة عدم الآخر
قلنا هذا باطل لأن الأمة مجمعة على أن الحيض يمنع من الوطء شرعا وذلك يقتضى أن تكون علة سواء وجد هذا القيد العدمي أم لا
أما المعارضة الأولى فجوابها أن الحكم الحاصل بالعلة السابقة إنما يمتنع حصوله بالعلة اللاحقة إذا فسرنا العلة بالمؤثر أما إذا فسرناها بالمعرف فلم قلت إنه يمتنع
وأما الثانية في مبنية على أن ما لا يكون مؤثرا في الحكم لذاته يجعله الشارع مؤثرا فيه وقد تقدم إبطال هذه القاعدة
وأما الثالثة فلا نسلم أن المناسبة شرط العلية ولو سلمناها فلم لا يجوز أن يشترك الحكمان في جهة واحدة ثم إن
العلة تناسبهما بحسب ذلك الوجه الواحد
وأعلم أنه يمكن فرض الكلام في صورة يسقط عنها كثير من الأسئلة وهى ما إذا جمعت لبن زوجة أخيك وأختك وجعلته في حلق المرتضعة دفعة واحدة فإنها تحرم عليك لأنك خالها وعمها ولا تتوجه في هذه الصورة أكثر تلك الأسئلة
المسألة الثانية
الحق أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين والدليل عليه وجهان الأول أن الإنسان إذا أعطى فقيرا فقيها أحتمل أن يكون الداعي له إلى الإعطاء كونه فقيرا فقط أو كونه فقيها فقط أو مجموعهما أو لا لواحد منهما
فهذه الاحتمالات الأربعة متنافية لأن قولنا الداعي له إلى الإعطاء هو الفقر لا غير ينافي أن يكون غير الفقر داعيا أو جزءا من الداعي
وإذا كانت هذه الاحتمالات متنافية فإن بقيت على حد التساوى أمتنع الحصول ظن حصول كل واحد منها على التعيين فلا يجوز الحكم بكونه علة
وإن ترجح بعضها فذلك الترجيح يحصل بأمر وراء المناسبة والاقتران لأن ذلك مشترك بين الأربعة وحينئذ يكون الراجح هو العلة دون المرجوح
الثاني أن الصحابة أجمعوا على قبول الفرق لأن عمر لما شاور
عبد الرحمن في قضية المجهضة قال إنك مؤدب ولا أرى عليك شيئا فقال على إن لم يجتهد فقد غشك وإن اجتهد فقد أخطأ أرى عليك الغرة
وجه الاستدلال به أن عبد الرحمن شبهه بالتأديب المباح وأن عليا فرق بينه وبين سائر التأديبات بأن التأديب الذي يكون من جنس
التعزيزات لا تجوز فيه المبالغة المنتهية إلى حد الإتلاف وذلك يدل على إجماعهم على قبول الفرق
وهو يقدح في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين والله أعلم
الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك
وقبل الخوض في تلك الأشياء نذكر تقسيمات العلة
التقسيم الأول
كل حكم ثبت في محل فعلة ذلك الحكم إما نفس ذلك المحل أو ما يكون جزءا من ماهيته وداخلا فيه أو ما يكون خارجا عنهوالخارج إما أن يكون أمرا عقليا أو شرعيا أو عرفيا أو لغويا
والعقلى أما أن يكون صفة حقيقية أو إضافية أو سلبية أو ما يتركب من هذه الأقسام وهى الصفة الحقيقية مع الإضافية أو مع السلبية
مثال التعليل بالصفة الحقيقية فقط مطعوم فيكون ربويا
مثال الإضافية قولنا مكيل فيكون ربويا
مثال السلبية قولنا في طلاق المكره لم يرض به فلا يقع
مثال الحقيقية مع الإضافية قولنا بيع صدر من الأهل في المحل
مثال الحقيقية مع السلبية قولنا قتل بغير حق
مثال الحقيقية والإضافية والسلبية معا قولنا قتل عمد عدوان
مثال الوصف الشرعي قولنا في المشاع يجوز بيعه فتجوز هبته
مثال العرفي قولنا في بيع الغائب انه مشتمل على جهالة مجتنبة في العرف
مثال الاسم قولنا في النبيذ أنه مسمى بالخمر فيحرم كالمعتصر من العنب
وأعلم أن التعليل بجزء مسمى المحل إن كان بعلة قاصرة وجب أن يكون بالجزء الذي يمتاز ذلك المحل به عن غيره وأن لا يحصل الحكم في ذلك المشارك فتصير القاصرة متعدية
وإن كان بعلة متعدية وجب التعليل بالجزء الذي يشارك غيره وإلا لم توجد تلك العلة في غيره فتصير العلة المتعدية قاصرة
التقسيم الثاني
العلة والحكم إما أن يكونا ثبوتيين أو عدميين وهذان القسمان لا نزاع في صحتهماوإما أن يكون الحكم ثبوتيا والعلة عدمية وفيه نزاع
وإما أن يكون الحكم عدميا والعلة ثبوتية وهذا يسميه الفقهاء تعليلا بالمانع واختلفوا في أنه هل من شرطه وجود المقتضي
التقسيم الثالث
العلة إما أن تكون فعلا للمكلف كالقتل الموجب للقصاص أو لا تكون كالبكارة في ولاية الإجبار عندناالتقسيم الرابع
الوصف المجعول علة أما أن يكون لازما للموصوف ككون البر مطعوما أو لا يكون فحينئذ يكون متجددا
وذلك المتجدد إما أن يكون ضروريا بحسب العادة وهو مثل انقلاب العصير خمرا والخمر خلا
أو لا يكون وهو إما أن يكون متعلقا بأختيار أهل العرف ككون البر مكيلا أو بأختيار الشخص الواحد كالردة والقتل
التقسيم الخامس
العلة إما أن تكون ذات أوصاف كقولنا قتل عمد عدوان أو لا تكون كقولنا التفاح مطعوم فيكون ربوياالتقسيم السادس
العلة قد تكون وجه المصلحة ككون الصلاة ناهية عن الفحشاء وكون الخمر موقعة للبغضاءوقد تكون أمارة المصلحة كما إذا جعلنا جهالة أحد البدلين
علة في فساد البيع مع أنا نعلم أن فساد البيع في الحقيقة معلل بما يتبع الجهالة من تعذر التسليم ألا ترى أن جواز البيع ثابت حيث لا تمنع الجهالة من صحة التسليم كبيع صبرة من الطعام مشار إليها لصحة تسليمها وإن كان مجهول القدر
التقسيم السابع
الوصف قد يعلم وجوده بالضرورة ككون الخمر مسكرا أو مطربا وذلك إما أن يعلم بالضرورة كونه من الدين ككون الجماع في نهار رمضان مفسدا للصوم وقد لا يكون كذلك وأمثلته ظاهرةالمسألة الأولى
اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم والحق أن العلة إما أن تكون قاصرة أو متعديةفإن كان الأول صح التعليل بمحل الحكم سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة لأنه لا استبعاد في أن يقول الشارع
حرمت الربا في البر لكونه برا
أو يعرف كون البر مناسبا لحرمة الربا
فإن قلت لو كان محل الحكم علة للحكم لكان الشيء الواحد فاعلا وقابلا معا وهو محال لوجهين
الأول أن المفهوم من كونه قابلا غير المفهوم من كون فاعلا ولذلك صح تعقل كل واحد منهما مع الذهول عن الآخر فهذان المفهومان إما أن يكونا داخلين في ذلك الشيء أو خارجين عنه أو أحدهما داخلا والآخر خارجا
فإن كان الأول كان ذلك الشيء مركبا في نفسه والجزء الذي هو ملحوق الفاعلية غير الجزء الذي هو ملحوق القابلية فلا يكون الشيء الواحد قابلا وفاعلا
وإن كان الثاني كان هذان الأمران الخارجان عن تلك الماهية لاحقين لها وكل لاحق معلول فيعود الأمر في أن المفهوم من كون تلك الماهية علة لأحد اللاحقين غير المفهوم من
كونه علة للاحق لآخر ويكون الكلام في هذين المفهومين كما في الأول فيلزم التسلسل وهو محال
وإن كان أحدهما داخلا في الماهية والآخر خارجا عنها لزم كون الماهية مركبة لأن كل ماله جزء فهو مركب ولزم أن يكون إما الفاعلية أو القابلية جزءا من الماهية وذلك محال لأن الفاعلية والقابلية نسبة بين الماهية وبين غيرها والنسبة بين الشيء وبين غيره خارجة عن الماهية والخارج عن الشيء لا يكون داخلا فيه فلا يمكن أن تكون القابلية أو الفاعلية داخلة في الماهية
الثاني وهو أن نسبة القابل إلى المقبول نسبة الإمكان ونسبة المؤثر إلى الأثر نسبة الوجوب فلو كان الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد مؤثرا وقابلا لزم كون النسبة الواحدة موصوفة بالوجوب وبالإمكان معا وهو محال
قلت قد بينا في كتبنا العقلية ما في هذين الوجهين من المغالطة
وأما إن كانت العلة متعدية لم يصح أن يكون محل الحكم علة للحكم لأن العلة المتعدية هى التي توجد في غير مورد النص وخصوصية مورد النص يستحيل حصولها في غيره لأن الشيء لا يكون نفس غيره
المسألة الثانية
الوصف الحقيقي إذا كان ظاهرا مضبوطا جاز التعليل به أما الذي لا يكون كذلك مثل الحاجة إلى تحصيل المصلحة ودفع المفسدة وهى التي يسميها الفقهاء بالحكمة فقد اختلفوا في جواز التعليل به والأقرب جوازه لنا أنا إذا ظننا استناد الحكم المخصوص في مورد النص إلى الحكمة المخصوصة ثم ظننا حصول تلك الحكمة في صورة أخرى تولد لا محالة من ذنيك الظنين ظن حصول الحكم في تلك الصورة والعمل بالظن واجب على ما تقدم
فإن قيل لا نزاع في أنه لو حصل ظن تعليل الحكم في الأصل بتلك الحكمة ثم حصل ظن حصول تلك الحكمة في صورة أخرى أنه يلزم حصول مثل حكم الأصل في تلك الصورة الأخرى لكن النزاع في أن ذينك الظنين هل هما ممكنا الحصول أم لا وأنتم ما دللتم على جوازه
ونحن نبين امتناعه من وجوه
الأول أن الحكم إما يعلل بالحاجة المطلقة أو يعلل بالحاجة المخصوصة
والأول باطل وإلا لكان كل حاجة معتبرة
والثاني أيضا باطل لأن الحاجة أمر باطن فلا يمكن الوقوف على مقاديرها وامتياز كل واحدة من مرابتها التي لا نهاية لها عن المرتبة الأخرى وإذا تعذر تعيينه تعذر التعليل بذلك المتعين
الثاني لو صح تعليل الحكم بالحكمة لما صح تعليله بالوصف وتعليله بالوصف جائز فتعليله بالحكمة غير جائز
بيان الملازمة أن شرع الحكم لابد وأن يكون لفائدة عائدة إلى العبد
لإنعقاد الإجماع على أن الشرائع مصالح إما وجوبا كما هو قول المعتزلة أو تفضلا كما هو قولناوإذا كان كذلك فالمؤثر الحقيقي في الحكم هو الحكمة
أما الوصف فليس بمؤثر ألبتة وإنما جعل مؤثرا لاشتماله على الحكمة التي هي المؤثرة
إذا ثبت هذا فنقول لو أمكن إستناد الحكم إلى الحكمة لما جاز استناده إلى الوصف لأن كل ما يقدح في استناده إلى الحكمة يقدح في استناده إلى الوصف لأن القادح في الأصل
قادح في الفرع
وقد يوجد ما يقدح في الوصف ولا يكون قادحا في الحكمة لأن القادح في الفرع قد لا يكون قادحا في الأصل فاستناد الحكم إلى الوصف مع إمكان استناده إلى الحكمة تكثير لإمكان الغلط من غير حاجة إليه وإنه لا يجوز ولما رأينا أنه جاز التعليل بالوصف علمنا أنه إنما جاز لتعذر التعليل بالحكمة
الثالث لو جاز التعليل بالحكمة لوجب طلب الحكمة والطلب لها غير واجب فالتعليل بها غير جائز
بيان الملازمة
أن المجتهد مأمور بالقياس عند فقدان النص ولا يمكنه القياس إلا عند وجدان العلة ولا يمكنه وجدانها إلا بعد الطلب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبفإذن طلب العلة واجب وإذا كانت الحكمة علة كان طلبها واجبا
بيان أن طلب الحكمة غير واجب
أن الحكمة لا تعرف إلا بواسطة معرفة الحاجات والحاجات أمور باطنة لا يمكن معرفة مقاديرها إلا بمشقة شديدة فوجب أن لا تكون هذه المعرفة واجبة لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج
الرابع أن استقراء الشريعة يدل على أن الأحكام معللة بالأوصاف لا بالحكم لأنا لو فرضنا حصول الأوصاف الجلية كالبيع والنكاح والهبة عارية عن المصالح لاستندت الأحكام إليها
ولو فرضنا حصول المصالح دون هذه الأوصاف لم تثبت بها الأحكام الملائمة لها وذلك يدل ظاهرا على امتناع التعليل بالحكم
الخامس الدليل ينفي التمسك بالعلة المظنونة لقوله تعالى إن بعض الظن إثم وقوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا خالفناه في الأوصاف الجلية لظهورها والحاجة ليست كذلك فتبقى على الأصل
السادس أن الحكمة تابعة للحكم لأن الزجر تابع لحصول القصاص وعلة الشيء يستحيل تأخيرها عن الشيء فالحكمة لا تكون علة للحكم
والجواب قوله ما الدليل على جواز أن يحصل لنا ظن أن الحكم في الأصل معلل بالحكمة
قلنا لا نزاع في أن المناسبة طريق كون الوصف علة والمعنى بذلك أنا نستدل بكون الوصف مشتملا على المصلحة على كونه علة فلا يخلو إما أن يكون الدال على عليته اشتماله على مطلق المصلحة أو اشتماله على مصلحة معينة
والأول باطل وإلا لكان كل وصف مشتمل على مصلحة كيف كانت علة لذلك الحكم
ولما بطل القسم الأول تعين الثاني فنقول إما أن يمكن الاطلاع على المصلحة المخصوصة
أو لا يمكن
فإن امتنع الاطلاع على المصلحة المخصوصة امتنع الاستدلال بكون الوصف مشتملا عليها على كونه علة لأن العلم بإشتمال الوصف عليها موقوف على العلم بها وحيث لم يمتنع هذا الاستدلال علمنا أن الإطلاع على خصوصيتها ممكن
وبهذا الحرف ظهر الجواب عن قوله المصالح أمور باطنة فلا يمكن الاطلاع عليها
قوله لو جاز التعليل بالحكمة لما جاز التعليل بالوصف
قلنا التعليل بالحكمة وإن كان راجحا على التعليل بالوصف من الوجه الذي ذكرت فالتعليل بالوصف راجح على التعليل بالحكمة من وجه آخر وهو سهولة الاطلاع على الوصف وعسر الاطلاع على الحكمة فلما كان كل واحد منهما راجحا من وجه مرجوحا من وجه آخر حصل الاستواء
قوله لو صح التعليل بالحكمة لوجب طلبها
قلنا نحن وإن اختلفنا في جواز تعليل الحكم لكنا اتفقنا على أن كون الوصف علة للحكم معلل بالحكمة فان لم يقتض ذلك وجوب طلب الحكمة فقد بطل قولك
وإن اقتضى وجوب طلبها فقد بطل قولك أيضا
قوله الاستقراء دل على تعليل الأحكام بالأوصاف لا بالحكمة
قلنا لا نسلم بل التعليل بالحكم حاصل في صور كثيرة مثل التوسط في إقامة الحد بين المهلك والزاجر وكذا الفرق بين العمل اليسير والكثير
قوله النافي للقياس قائم ترك العمل به في الوصف لظهوره
قلنا الحكمة علة لعلية الوصف فأولى أن تكون علة للحكم
قوله الحكمة ثمرة الحكم
قلنا في الوجود الخارجى لا في الذهن ولهذا قيل أول الفكر آخر العمل
نكتة أخرى في المسألة الحكمة علة لعلية العلة فأولى أن تكون علة للحكم
بيانه أن الوصف لا يكون مؤثرا في الحكم إلا لاشتماله على جلب نفع أو دفع
مضرة فكونه علة معللة بهذه الحكمة فإن لم يكن العلم بتلك الحكمة المخصوصة استحال التوصل به الجعل الوصف علةوإن أمكن ذلك وهو مؤثر في الحكم والوصف ليس بمؤثر كان لإسناد الحكم إلى الحكمة المعلومة التي هي المؤثرة أولى من إسناده إلى الوصف الذي هو في الحقيقة ليس بمؤثر
المسألة الثالثة
المعللون بالحكمة لما قيل لهم أن الحكمة مجهولة القدر فإن حاجة الإنسان في مبدأ زمان الجوع دون حاجته في مقطع زمان الجوع ولما كان الغالب فيها التفاوت لم يكن القدر الموجود في الأصل ظاهر الوجود في الفرع فلم يصج القياسفمن الناس من أجاب عنه بأنا نعلل بالقدر المشترك بين الصورتين لأنه حصل في الأصل قدر معين من المصلحة وفي الفرع قدر معين وكل مقدارين فلابد وأن يكون بينهما اشتراك في قدر معين وذلك القدر المشترك يناسب التعليل به لكونها مصلحة مطلوبة الوجود
فإذا قيل لهم إنه ينتقض بالحاجة الفلانية فإنها غير معتبرة قالوا نحن إنما عللنا بالقدر المشترك بين الأصل والفرع ونحن لا نسلم أن ذلك القدر المشترك حاصل في صورة النقض
واعلم أن هذا الكلام ضعيف وذلك لأنه يحتمل أن لا يكون بين القدر المشترك الحاصل في الأصل والحاصل في الفرع اشتراك إلا في مسمى كونه مصلحة والتعليل بهذا المسمى غير ممكن وإلا حصل النقض بجميع المصالح المنفكة عن هذا الحكم
وأما الاشتراك بين القدرين في أمر أخر وراء عموم كونه مصلحة
فغير معلوم ولا مظنون وإذا كان وجوده غير ظاهر لم يكن التعليل به ظاهرا
المسألة الرابعة
يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاءلنا أنه قد يحصل دوران الحكم مع بعض العدمات والدوران يفيد ظن العلية والعمل بالظن واجب
احتجوا على أن العدم لا يصلح للعلية بوجوه
أحدها أن العلية مناقضة للاعلية المحمولة على العدم فاللاعلية عدمية والعلية ثبوتية فلو حملناها على العدم المحض كان النفى المحض موصوفا بالصفة الوجوديةولو جوزنا ذلك لما أمكننا أن نستدل بكون الجدار وكثافته وحصوله في الحيز على كون الموصوف بهذه الصفات موجودا وهو سفسطة
وثانيها أن العلة لابد وأن تتميز عما ليس بعلة سواء أريد بها المؤثر أو المعرف أو الداعي والتمييز عبارة عن كون كل واحد من المتميزين مخصوصا في نفسه بحيث لا يكون تعين هذا حاصلا لذلك ولا تعين ذلك حاصلا لهذا وهذا غير معقول في العدم الصرف لأنه نفي محض ولأنه لو جاز وقوع التمييز فيه لجاز أن يقال المؤثر في العالم عدم صرف ليست أقول ذات معدومة على ما ذهب إليه القائلون بأن المعدوم شيء لأن ذلك عندهم ثابت بل الإلزام أن نجعل النفي المحض الذي لا يكون
ذاتا ولا عينا ولا أمرا من الأمور مؤثرا في العالم وذلك مما يسد باب إثبات الصانع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
وثالثها أن العدم إما أن يكون عاريا عن النسبة من كل الوجوه أو لا يكون
فإن كان الأول لم يكن له اختصاص بذات دون ذات وبوقت دون وقت فلا يجوز جعله علة لحكم معين في وقت معين وفي شخص معين
وإن كان له انتساب بوجه ما كان ذلك الانتساب أمرا ثبوتيا ضرورة كونه نقيضا للانتساب فيلزم وصف العدم بالوجود وهو محال
ورابعها أن المجتهد إذا بحث عن علة الحكم لم يجب عليه سبر الأوصاف العدمية فإنها غير متناهية مع أنه يجب عليه سبر كل وصف يمكن كونه علة وذلك يدل على أن الوصف العدمى لا يصلح للعلية
وخامسها قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
والعدم نفي محض فلا يكون من سعيه فوجب أن لا يترتب عليه حكم فإن كل حكم يثبت فإنه يحصل للإنسان بسببه إما جلب منفعة أو دفع مضرة
فثبت أن الوصف العدمى لا يمكن أن يكون علة
فإن قلت الامتناع عن الفعل عدم مع أنه قد يكون مأمورا به ويكون منشأ للمصالح ودفع المفاسد
قلت الامتناع عن الفعل عبارة عن أمر يفعله الإنسان فيترتب عليه عدم ذلك الشيء فثبت أن الامتناع ليس عدما محضا
والجواب عن الأول
ما ذكرتموه من الدلالة على أن العلية صفة ثبوتية معارض بدليل آخر وهو أنها لو كانت ثبوتية لكانت من عوارض ذات العلة فكانت مفتقرة إلى تلك الذات وكانت ممكنة وكانت مفتقرة إلى العلة فكانت علية العلة لتلك العلة زائدة عليها ولزم التسلسل
وعن الثاني نسلم أنه لابد وأن تكون العلة متميزة عما ليس بعلة لكن لا نسلم أن التميز يستدعى كون المتميز ثبوتيا فإن عدم أحد الضدين عن المحل يصحح حلول الضد الآخر فيه وعدم ما ليس بضد ليس كذلك
وأيضا عدم اللازم يقتضى عدم الملزوم وعدم ما ليس بلازم لا يقتضى ذلك فقد حصل الامتياز في العدمات
وعن الثالث أن العلة عدم مخصوص
قوله فالخصوصية صفة قائمة بالنفى المحض
قلنا لا نسلم أن الخصوصية أمر ثبوتي فإنها لو كانت أمرا ثبوتيا لكانت في نفسها أمرا مخصوصا فلزم التسلسل
وعن الرابع لا نسلم أن المجتهد لا يبحث في السبر والتقسيم عن الأوصاف العدمية
سلمنا ذلك لكن إسقاط ذلك التكليف لتعذره فإن العدمات غير متناهية
وعن الخامس
أنا نعلم بالضرورة كوننا مكلفين بالامتناع فدل على أن العدم قد يكون متعينا
قوله الامتناع عبارة عن فعل يترتب عليه العدم
قلنا لو كان الامتناع عبارة عن فعل يترتب عليه العدم لكان الممتنع عن الفعل فاعلا وذلك محال
المسألة الخامسة
للمانعين من التعليل بالعدم أن يمنعوا من التعليل بالأوصاف الإضافية محتجين بأنها عدم والعدم لا يكون علة وإنما قلنا إنها عدم لأن مسمى الإضافة ليس أمرا وجوديا وإذا لم يكن المسمى وجوديا امتنع أن يكون شيء من الإضافات المخصوصة أمرا وجوديا
وإنما قلنا أن مسمى الإضافة ليس أمرا وجوديا لأنه لو كان هذا المسمى وجوديا لكان أينما حصل هذا المسمى كان وجوديا
فإذا فرضنا في إضافة ما كونها أمرا وجوديا كانت لا محالة صفة لمحل فكان حلولها في ذلك المحل إضافة بينها وبين ذلك المحل فكان مسمى الإضافة حاصلا في حلول تلك الإضافة في ذلك المحل
وإذا كان ذلك المسمى أمر وجوديا كانت إضافة الإضافة أمرا وجوديا زائدا على الإضافة إلى غير نهاية فثبت أن مسمى الإضافة يمتنع أن يكون وجوديا
وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يكون شيء من الإضافات
المخصوصة وجوديا لأن الإضافة المخصوصة ماهية مركبة من الإضافة ومن الخصوصية فلو كانت أمرا وجوديا لكان الوجود إما قيد الإضافة أو قيد الخصوصية
والأول باطل لما تقدم
والثاني أيضا باطل لأن خصوصية الإضافة صفة للإضافة فلو كانت الخصوصية أمرا ثبوتيا لزم حلول الوجود في النفى المحض وهو محال
فثبت أن سائر الإضافات يمتنع أن يكون موجودا فهو معدوم والتعليل بالعدم غير جائز على ما تقدم
والجواب لا نسلم أن الإضافات أمور عدمية والتسلسل مدفوع لاحتمال أن تكون الإضافة إلى محلها لذاتها
وأن سلمنا أنها عدمية في الحقيقة لكنها ثبوتية في المعتقدات فيحسن جعلها علة للأحكام الشرعية
وإن سلمنا كونه عدمية مطلقا ولكن لا نسلم أن الأمور الذهنية لا تصلح للعلية والله أعلم
المسألة السادسة
تعليل الحكم الشرعي جائز خلافا لبعضهملنا
أن الدوران يفيد ظن العلية فإذا حصل في الحكم الشرعي
حصل ظن العلية
واحتج المانعون بأن قالوا الدوران لا يفيد ظن العلية فيما له صلاحية
العلة ولا نسلم أن الحكم الشرعي يصلح أن يكون علة للحكم الشرعيوبيانه بأمور
أحدها أن الحكم الشرعي الذي فرض علة يحتمل كونه متقدما على الحكم الذي جعل معلولا ويحتمل كونه متأخرا ويحتمل كونه مقارنا
وعلى تقدير التقدم لم يصلح للعلية وإلا لزم تخلف الحكم عن علته
وعلى تقدير التأخر لم يصلح للعلية لأن المتأخر لا يكون علة للمتقدم
وعلى تقدير المقارنة يحتمل أن تكون العلة هو وأن تكون غيره
فإذن هو على التقديرات الثلاثة لا يكون علة وعلى تقدير واحد يكون علة ولا شك أن العبرة في الشرع بالغالب لا بالنادر فوجب الحكم بأنه ليس بعلة
وثانيها أن تفسير العلة إما بالمعرف أو الداعي أو المؤثر فإن فسرناها بالمعرف امتنع تعليل حكم الأصل بحكم آخر لأن المعرف لحكم الأصل هو النص لا غيره
وأما الثاني والثالث فباطلان لأن من يقول بالمؤثر والداعي يقول المؤثر والداعي جهات المفاسد والمصالح فالقول بأن الحكم الشرعي مؤثر أو داع خرق للإجماع وهو باطل
وثالثها أن شرط العلة التقدم على المعلول وتقدم أحد الحكمين على الآخر غير معلول فإذن شرط العلية مجهول فلا يجوز الحكم بالعلية
ورابعها أن الشرع إذا أثبت حكمين في صورة واحدة فليس لأحدهما مزية على الآخر في الوجود والافتقار والمعلومية فليس جعل أحدهما
على للأخر أولى من العكس فإما أن نحكم بكون كل واحدة منهما على للآخر وهو محال أو لا يكون واحد منهما على للآخر وهو المطلوب
والجواب عن الأول لا نسلم أن بتقدير التأخر لا يصلح للعلية لأن المراد من
العلة المعرف والمتأخر يجوز كونه معرفا للمتقدموعن الثاني أنا نفسر العلة المعرف
قوله الحكم محل النص معرف بالنص لا بغيره
قلنا سبق الجواب عنه في مقدمة الباب الثاني
وعن الثالث لا نسلم أن التقدم شرط العلية على ما بيناه
وعن الرابع نقول قوله ليس جعله علة للآخر بأولى من العكس
قلنا لا نسلم فإنه ربما لا تتأتى المناسبة من الجانب الآخر وإن سلمنا ذلك فنقول إنه يجوز كون كل واحد منهما على لصاحبه بمعنى كون كل واحد منهما معرفا لصاحبه
فرع إذا جوزنا تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي فهل يجوز تعليل الحكم
الحقيقي بالحكم الشرعيومثاله أن نعلل إثبات الحياة في الشعر بأنه يحرم الطلاق ويحل النكاح فيكون حيا كاليد
والحق انه جائز لأن المراد من هذه العلة المعرف ولا يمتنع أن يجعل الحكم الشرعي معرفا للأمر الحقيقي
المسألة السابعة
يجوز التعليل بالأوصاف العرفية وهي الشرف والخسة والكمال والنقصان ولكن بشرطين
أحدهما أن يكون مضبوطا متميزا عن غيره
والثاني أن يكون مطردا لا يختلف باختلاف الأوقات فإنه لو لم يكن كذلك لجاز أن لا يكون ذلك العرف حاصلا في زمان الرسول صلى الله عليه و سلم وحينئذ لا يجوز التعليل به
المسألة الثامنة
يجوز التعليل بالوصف المركب عند الأكثرين وقال قوم لا يجوزلنا أن المناسبة مع الاقتران والدوران تفيد ظن العلية فيجب العمل به
احتج المنكرون بأمور ثلاثة
أحدها أن جواز التركيب في العلة يوجب تطرق النقض إلى العلة العقلية واللازم محال فالملزوم مثلهبيان الملازمة أن كل ماهية مركبة فان عدم كل واحد من أجزائها علة لعدم
علية تلك الماهية لأن كون الماهية علة صفة من صفات الماهية وتحقق الصفة يتوقف على تحقق الموصوفوإذا كانت كذلك كان عدم كل واحد من أجزاء الماهية علة تامة لعدم علية تلك الماهية فإذا عدم جزء من أجزائها فقد عدمت العلية فإذا عدم بعد ذلك جزء آخر لم يكن عدم هذا الجزء الثاني علة لعدم علية تلك الماهية لأن ذلك قد حصل عند عدم الجزء الأول فلا يحصل مرة أخرى بعدم الجزء الثاني فقد حصل عدم جزء الماهية مع أنه لم يترتب عليه عدم علية تلك
الماهية فقد وجد النقض في العلة العقلية لأن كون عدم جزء الماهية علة لعدم علية الماهية أمر حقيقي سواء كانت علية الشيء عقلية أو وضعية
فإن قلت فهذا يقتضى أن لا يكون في الوجود ماهية مركبة لأن عدم كل واحد من أجزائها علة مستقلة لعدم تلك الماهية ويعود المحال
قلت ليست الماهية أمرا وراء مجموع تلك الأجزاء فلم يكن عدم أحد تلك الأجزاء علة لعدم شيء آخر
وأما علية الماهية فهى حكم زائد على ذات الماهية وعدمها معلل بعدم كل واحد من أجزاء الماهية فظهر الفرق
وثانيها أن كون الشيء علة لغيره صفة لذلك الشيء سواء حصلت له تلك الصفة بذاته أو بالجعل
فإذا كان الموصوف بالعلية أمرا مركبا فإما أن يقال حصلت
تلك الصفة بتمامها لكل واحد من تلك الأجزاء وهو محال
أما أولا فلأنه يلزم الصفة الواحدة في المحال الكثيرة وهو محال
وأما ثانيا فلأنه يلزم كون كل واحد من تلك الأجزاء علة تامة لأنه لا معنى لكون الشيء علة إلا حصول العلية فيه
وإما أن يقال حصل في كل واحد من أجزاء العلة جزء من تلك العلية وهذا أيضا محال لأنه يقتضى انقسام الصفة العقلية حتى يكون للعلية نصف وثلث وربع وهو محال
وثالثها أن كل واحد من تلك الأجزاء لم يكن علة فعند انضمامها إما أن يكون قد حدث أمر لم يكن
أو ما كان كذلك
فإن حدث أمر فالمقتضي لحدوث ذلك الأمر أما كل واحد من تلك الأجزاء أو مجموعها
فإن كان الأول كان كل واحد من الأجزاء مستقلا بأقتضاء العلية فوجب كون كل واحد منها علة تامة وذلك محال
وإن كان الثاني كان الكلام في اقتضاء ذلك المجموع لذلك الأمر الحادث كالكلام في اقتضاء ذلك المجموع للعلية فيلزم أن يكون بواسطة حدوث شيء آخر ولزم التسلسل وهو محال
وإن قلنا إنه لم يحدث أمر لم يكن حاصلا فتلك الأجزاء حالة الاجتماع كهى حالة الانفراد ولكنها حالة الانفراد ما كانت علة فكذا عند الاجتماع
والجواب عن الأول
أن النقض إنما يلزم لو جعلنا عدم جزء الماهية علة لعدم علية الماهية وهو بناء على كون العدم علة وهو ممنوعوعن الثاني
أن العلية ليست صفة ثبوتية وإلا لزم التسلسل على ما قررناه
وإذا لم تكن صفة ثبوتية امتنع القول بأنها إما أن تحل كل واحد من الأجزاء بتمامها أو تنقسم بحسب انقسام أجزاء الماهية
وعن الثالث أنه منقوض بكل واحد من العشرة فإنه ليس بعشرة وعند اجتماعها يكون المجموع عشرة فكذا هاهنا
فرعان
الأول نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله عن بعضهم أنه قال لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة وهذا الحصر لا أعرف له حجة الثاني في الفرق بين جزء العلة ومحلها وشرط ذات العلة وشرط عليتها وقبل الخوض فيه لا بد من حد الشرط وذكروا فيه وجهين
الأول أنه الذي يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يكون جزءا من العلة
والثاني أنه الذي يلزم من عدمه مفسدة دافعة لوجود الحكم
إذا عرفت ذلك فمن الناس من أنكر هذا الفرق ومنهم المثبتون للطرد والمنكرون لتخصيص العلة
واحتجوا عليه بأن العلة الشرعية ما يكون معرفا للحكم وهو إنما يكون معرفا للحكم عند اجتماع كل القيود من الشرط والإضافة إلى الأهل والمحل فيكون كل واحد من هذه القيود جزءا من المعرف للحكم فيكون جزءا من العلة
بلى لا ننكر لأن بعض هذه القيود أقوى في الوجود من بعض
فإن القتل له ذات وحقيقة ثم له صفة وهي إضافته إلى القاتل وإلى المقتول وذات القتل أقوى في الوجود من هذه الإضافات لاحتياجها إليه في الوجود
وقد يكون بعض تلك القيود مناسبا دون البعض أو يكون بعضها أقوى في المناسبة من بعض ولكن مع تسليم هذا المقام فالمعتبر في تعريف الحكم هو المجموع
وحينئذ لا يبقى بين جزء العلة وبين شرطها فرق
وفائدة هذا البحث أنه إذا صدر بعض تلك الأجزاء عن إنسان وصدر الثاني عن إنسان آخر فإن كانت تلك الأجزاء متساوية في القوة و المناسبة اشتراكا وإلا نسب الفعل إلى فاعل الجزء الأقوى وهذه الفائدة حاصلة سواء سميناها جزء العلة أو شرطها
ومن الناس من سلم الفرق وزعم أن العلة إنما تعرف عليتها بالنص أو بالاستنباط
فإن كان الأول فالقدر الذي دل النص على كونه مناطا للحكم هو العلة وسائر القيود التي عرف اعتبارها بدلائل منفصلة نجعلها شرائط
وإن كان الثاني فالذي يكون مناسبا هو العلة والذي يكون معتبرا في تحقق المناسبة ولا يكون كافيا فيها هو جزء العلة والذي لا يكون مناسبا ولا جزءا منه فهو الشرط
هذا إذا عرفنا علية الوصف بالمناسبة
أما إذا عرفناها بسائر الطرق لم يتجه هذا الفرق
المسألة التاسعة
اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم مثل تعليل تحريم الخمر بأن العرب سمته خمرا فإنا نعلم بالضرورة أن مجرد هذا اللفظ لا أثر لهفإن أريد به تعليله بمسمى هذا الاسم من كونه مخامرا للعقل فذلك يكون تعليلا بالوصف لا بالاسم
المسألة العاشرة
مذهب الشافعي رضى الله عنه أن يجوز التعليل بالعلة القاصرة وهو قول أكثر المتكلمين وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز ووافقونا في العلة المنصوصةلنا أن صحة تعدية العلة إلى الفرع موقوفة على صحتها في نفسها فلو توقفت صحتها في نفسها على صحة تعديتها إلى الفرع لزم الدور
وإذا لم تتوقف على ذلك فقد صحت العلة في نفسها سواء كانت متعدية أو لم تكن
فإن قيل لم لا يجوز أن يقال إن صحتها في نفسها لا تتوقف على صحة تعديتها بل على صحة وجودها في غير الأصل وحينئذ ينقطع الدور
سلمنا ذلك ولكن وجد هاهنا ما يدل على فساد العلة القاصرة وهو من وجوه
الأول أن العلة القاصرة لا فائدة فيها وما لا فائدة فيه كان عبثا وهو على الحكيم غير جائز
وإنما قلنا إنه لا فائدة فيها لأن الفائدة من العلة التوسل بها إلى معرفة الحكم وهذه الفائدة مفقودة هاهنا لأنه لا يمكن في القاصرة أن يتوسل بها إلى معرفة الحكم في الأصل لأن ذلك معلوم في النص ولا يمكن التوسل بها إلى معرفة
الحكم في غير الأصل لأن ذلك إنما يمكن أن لو وجد ذلك الوصف في غير الأصل فإذا لم يوجد امتنع حصول تلك الفائدة
وإنما قلنا إن مالا فائدة فيه عبث وإن العبث غير جائز فذلك للإجماع
الثاني الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة لأنه اتباع الظن وهو غير جائز لقوله تعالى إن الظن لا يغنى من الحق شيئا ترك العمل به في العلة المعتدية لأن فيها فائدة وهى التوسل بها إلى معرفة الحكم في غير محل النص وهذه الفائدة مفقودة في القاصرة فوجب بقاؤها في الأصل
الثالث العلة الشرعية أمارة فلابد وأن تكون كاشفة عن شيء والعلة القاصرة لا تكشف عن شيء من الأحكام فلا تكون أمارة فلا تكون علة
والجواب قوله لم لا يجوز أن يقال صحة كونها علة موقوفة على صحة وجودها في
غير ذلك المحلقلنا لأن الحاصل في محل آخر لا يكون هو بعينه لاستحالة حلول الشيء الواحد في محلين بل يكون مثله
وإذا كان كذلك فنقول كل ما يحصل له من الصفات عند حلول مثله في محل آخر يكون ممكن الحصول له عند عدم حلول مثله في محل آخر لأن حكم الشيء حكم مثله فإذا أمكن
حصول كل تلك الأمور فبتقدير تحقق ذلك وجب أن تكون علة لأن تلك العلية ما حصلت إلا بسبب تلك الأمور
وأما المعارضة الأولى وهى أنه لا فائدة فيها
قلنا لا نسلم
قوله الفائدة أن يتوسل بها إلى معرفة الحكم
قلنا نسلم أن معرفة الحكم فائدة لكن لا نسلم أنه لا فائدة إلا هى فما الدلالة على هذا الحصر
ثم إنا نبين فائدتين أخريين
الأولى أن نعرف أن الحكم الشرعي مطابق لوجه الحكمة والمصلحة وهذه فائدة معتبرة لأن النفوس إلى قبول الأحكام المطابقة للحكم والمصالح أميل وعن قبول التحكم الصرف والتعبد المحض أبعد الثانية أنه لا فائدة أكثر من العلم بالشيء لأنا إذا علمنا الحكم ثم اطلعنا على علته صرنا عالمين أو ظانين بما كنا غافلين عنه وذلك محبوب القلوب
ولا يمتنع أيضا أن يكون لنا فيه مصلحة
سلمنا أنه لا بد وأن يتوسل بالعلة إلى معرفة الحكم لكن في جانب الثبوت أو في جانب العدم
الأول ممنوع
والثاني مسلم وهاهنا أمكن التوسل به إلى عدم الحكم
بيانه أنه إذا غلب على ظننا كون حكم الأصل معللا بعلة قاصرة امتنعنا من
القياس عليه فلا يثبت الحكم في الفرعفإن قلت يكفى في الامتناع من القياس أن لا نجد علة متعدية فإما التعليل بالعلة القاصرة فلا حاجة إليه في الامتناع من القياس
قلت يجوز أن يوجد في الأصل وصف متعد مناسب لذلك
الحكم فلو لم يجز التعليل بالعلة القاصرة لبقى ذلك الوصف المتعدى خاليا عن المعارض فكان يجب التعليل به
وحينئذ كان يلزم ثبوت الحكم في الفرع
أما لو جاز التعليل بالوصف القاصر صار معارضا لذلك الوصف المتعدى وحينئذ لا يثبت القياس ويمتنع الحكم
سلمنا أنه لا فائدة فيها فلم قلتم إنها تكون باطلة فإنه لا يمتنع كونها علة مؤثرة في الحكم مع أن الطالب لها يكون طالبا لما لا ينتفع به حين يتشاغل بطلب ما هو مستغن عنه
سلمنا أن مالا فائدة فيه لا يجوز إثباته ولكن لا يجوز ذلك قبل أن يعلم أنه لا فائدة فيه أو بعد أن يعلم ذلك
وهاهنا المستنبط للعلة حال طلبه لها لا يعلم أن تلك العلة متعدية أو قاصرة فلا يمكن منعه عن ذلك الطلب وبعد وقوفه على العلة القاصرة لا يمكن منعه عن معرفتها لأن ذلك خارج عن وسعه
سلمنا كل ما ذكروه ولكنه منقوص بالتنصيص على العلة القاصرة فإن كل ما ذكروه حاصل فيها مع جوازها
قوله الدليل ينفى القول بالعلة المظنونة
قلنا لا نسلم والتمسك بالآية سبق الجواب عنه في مسألة إثبات القياس
وأيضا قد بينا أن العلة المتعدية كما أنها وسيلة إثبات الحكم فالعلة القاصرة وسيلة إلى نفى الحكم فوجب كون القاصرة صحيحة لأنها على وفق النافي والمتعدية على خلافها
قوله هذه الأمارة لا تكشف عن حكمة
قلنا لا نسلم بل تكشف عن المنع من استعمال القياس
سلمناه لكنه يكشف عن حكمة الحكم
سلمناه لكنه منقوض بالعلة القاصرة المنصوصة
فرع اختلفوا في أن الحكم في مورد النص ثابت بالنص أو بعلة
النص
فقالت الحنفية لا يمكن ثبوته بالعلة لأن الحكم معلوم والعلة مظنونة والمظنون لا يكون طريقا إلى المعلوم وأصحابنا جوزوه
والخلاف فيه لفظى لأنا نعنى بالعلة هاهنا أمرا مناسبا يغلب على الظن أن الشرع أثبت الحكم لأجله وذلك مما لا يمكن إنكاره
المسألة الحادية عشرة
الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا لبعض الفقهاء العصريين مثاله قولهم الملك معنى مقدر شرعي في المحل أثره إطلاق التصرفات وربما قالوا الملك الحادث يستدعى سببا حادثا وذلك هو قوله بعت واشتريت وهاتان الكلمتان مركبتان من الحروف المتوالية وكل واحد من تلك الحرف لا يوجد عند وجود الحرف الآخر فإذن ليس لهاتين الكلمتين وجود حقيقي لكن لهما وجودا تقديريا وهو أن الشارع قدر بقاء تلك الحروف إلى حين حدوث الملك ضرورة أنه لا بد من وجود السبب حال حصول المسبب
وقد يذكرون هذا التقدير في جانب الأثر فيقولون إن من عليه الدين يكون ذلك الدين مقدرا في ذمته
واعلم إن هذا الكلام من جنس الخرافات لأن الوجوب إما أن يكون مفسرا بمجرد تعلق خطاب الشرع على ما هو مذهبنا
أو يكون الفعل في نفسه بحيث يكون للإحلال به مدخل في استحقاق الذم على ما هو قول المعتزلة
فإن كان الأول لم يكن لتعلق الخطاب حاجة إلى معنى محدث يكون علة له لأن ذلك التعلق قديم أزلى فكيف يكون معللا بالمحدث
وإن كان الثاني فالمؤثر في الحكم جهات المصلحة والمفسدة فلا حاجة فيه إلى بقاء الحروف
وأيضا فالمقدر يجب أن يكون على وفق الواقع والحروف لو وجدت مجتمعة لخرجت عن أن تكون كلاما فلو قدر الشرع بقاء الحروف التي حصل منها قوله بعت واشتريت لم يحصل عند اجتماعها هذا الكلام
وأما تقدير المال في الذمة فهو ساقط جدا بل لا معنى له إلا أن الشرع مكنه إما في الحال أو في الاستقبال من أن يطالبه بذلك القدر من المال فهذا معقول شرعا وعرفا
فأما التقدير في الذمة فهو من الترهات التي لا حاجة في العقل والشرع إليها
المسألة الثانية عشر هاهنا أبحاث
الأول العلة قد يكون لها حكم واحد وهو ظاهروقد يكون حكمها أكثر من واحد وتلك الأحكام إما أن تكون متماثلة أو مختلفة غير متضادة أو مختلفة متضادة
فالأول إما أن يكون في ذات واحدة أو في ذاتين والأول محال لامتناع اجتماع المثلين
والثاني جائز وهو كالقتل الذي حصل بفعل زيد وعمرو فإنه يوجب القصاص على كل واحد منهما
وأما الثاني وهو أن توجب أحكاما مختلفة غير متضادة فهو جائز كتحريم الإحرام ومس المصحف والصوم والصلاة بالحيض
وأما الثالث وهو أن توجب العلة أحكاما متضادة فلا يخلو أما أن يتوقف إيجابها لها على شرط أو لا يتوقف
فإن كان الأول فالشرطان إما أن لا يجوز اجتماعهما أو يجوز
فإن لم يجز جاز أن تكون العلة موجبة لحكمين متضادين عند حصول شرطين لا يجتمعان
وإن كان يجوز اجتماعهما فهو محال لأنهما إذا اجتمعا لم تكن العلة باقتضاء أحدهما أولى من اقتضاء الآخر فوجب أن تقتضيهما جميعا وهو محال
أو لا تقتضى واحدا منهما وحينئذ تخرج العلة عن أن تكون علة
وبهذا البيان يظهر أيضا أنه لا يجوز أن يتوقف اقتضاء العلة معلوليها المتضادين على شرط
الثاني من شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم وإلا لم يكن اقتضاء حصول الحكم لشيء أولى من اقتضائه لغيره
الثالث أن اقتضاءها معلولها قد يكون موقوفا على شرط مثل الزنا فإنه لا يوجب الرجم إلا بشرط الإحصان وقد لا يكون وهو ظاهر
الرابع العلة قد تكون علة لإثبات الحكم في الابتداء كالعدة في منع الحل
وقد تكون علة في الابتداء والانتهاء كالرضاع في إبطال النكاح
وقد تكون العلة قوية على الدفع لا على الرفع مثل العدة والردة فإنهما يدفعان النكاح ويرفعانه
وقد تكون قوية عليهما معا
المسألة الثالثة عشر
قد يستدل بذات العلة على الحكم وقد يستدل بعلية العلة على الحكمفالأول مثل أن يقال قتل عمد عدوان فيكون موجبا للقصاص
والثاني أن يقال القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص وقد وجد فيجب القصاص
فالأول صحيح
والثاني باطل لأنه لا فرق بين ماهية القتل وبين كونه سببا للقصاص فإنه قد يفهم كونه قتلا مع الذهول عن السببية وقد تفهم السببية مع الذهول عن كونه قتلا
والسببية أمر إضافي والأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على ثبوت كل واحد من المضافين فدعوى كون القتل سببا لوجوب القصاص
يتوقف على ثبوت القتل وثبوت وجوب القصاص لأن قولنا هذا سبب لذلك يستدعى تحقق هذا وتحقق ذاك حتى يحكم على هذا بأنه سبب لذاك
وإذا كانت دعوى السببية متوقفة على ثبوت الحكم أولا فلو استفدنا ثبوت الحكم من ذكر السببية لزم الدور وإنه محال فعلمنا أنه لا يمكن الاستدلال بعلية الوصف وسببيته على ثبوت الحكم
المسألة الرابعة عشر
تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودى لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضى لذلك الحكموهذه المسألة من تفاريع جواز تخصيص العلة فإنا إذا أنكرناه
امتنع الجمع بين المقتضي والمانع
أما إذا جوزناه جاء هذا البحث
والحق أنه غير معتبر لدليلين
الأول أن الوصف الوجودى إذا كان مناسبا للحكم العدمي أو كان دائرا معه وجودا وعدما حصل ظن أن ذلك الوصف علة لذلك العدم والظن حجة
والثاني أن بين المقتضى والمانع معاندة ومضادة والشيء لا يتقوى بضده بل يضعف به وإذا جاز التعليل بالمانع حال ضعفه فلأن يجوز ذلك حال قوته وهو حال عدم المقتضى كان أولى
واحتج المخالفو بأمور
أحدها أنا إذا عللنا انتفاء الحكم بالمانع فالمعلل إما عدم مستمر أو عدم متجدد والأول باطل لأن العدم المستمر كان حاصلا قبل حصول هذا المانع بل قبل الشرع والحاصل قبل يمتنع تعليله بالحاصل بعد
والثاني تسليم المقصود لأن عدم الحكم لا يحصل فيه التجدد إلا إذا امتنع من الدخول في الوجود بعد أن كان بعرضية الدخول في الوجود وذلك لا يتحقق إلا عند قيام المقتضي
وثانيها أن انتفاء الحكم لانتفاء المقتضى أظهر عند العقل من انتفائه لحصول المانع
وإذا كان كذلك فإما أن يكون ظن تحقق انتفاء المقتضى مثل ظن تحقيق وجود المانع أو أقوى منه أو أضعف منه
فان كان الأول امتنع تعليل عدم الحكم بوجود المانع لأن عدم المقتضى ووجود المانع لما استويا في الظن واختص عدم المقتضى بمزية وهى أن ظن اسناد عدم الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى وجود المانع كان ظن تعليل عدم الحكم بعدم المقتضي أقوى من تعليله بوجود المانع والأقوى راجح فيلزم أن لا يجوز تعليل عدم الحكم بالمانع وإما أن كان ظن عدم المقتضى
أظهر فالتقدير المذكور أظهر
وأما إن كان ظن عدم المقتضى مرجوحا بالنسبة إلى وجود المانع فظن العدم إنما يكون مرجوحا لو كان ظن الوجود راجحا وذلك يدل على أن التعليل بالمانع يتوقف على رجحان وجود المقتضى وهو المطلوب
وثالثها أن التعليل بالمانع يتوقف على بيان المقتضى عرفا فيتوقف عليه شرعا
أما الأول فلأن من قال الطير إنما لا يطير لأن القفص يمنعه فهذا التعليل موقوف على العلم بكون الطير حيا قادرا فإن بتقدير موت الطير يمتنع تعليل عدم الطيران بالقفص وكذا من علل عدم حضور زيد في السوق بحضور غريم له هناك لابد
أن يبين أنه كان قادرا على الحضور وإلا لما صح ذلك التعليل عرفا
وأما الثاني فلقوله عليه الصلاة و السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح
ورابعها أن عدم المقتضى مستلزم لعدم الحكم فلو حصل عدم المقتضى لامتنع إسناد ذلك العدم إلى وجود المانع لأن تحصيل الحاصل محال فثبت أنه لا بد من بيان وجود المقتضي
والجواب عن الأول
أن العلة الشرعية معرفة والمعرف يجوز تأخيره عن المعرف
قوله إنما يصير الحكم شرعيا إذا كان بحيث لو سكت الشرع لما ثبت
قلنا نحن لا نعنى بكون هذا الانتفاء شرعيا إلا أنه لم يعرف إلا من قبل الشرع وذلك حاصل بدون ما قلتموه
وعن الثاني أن مجرد النظر إلى وجود المانع يقتضى ظن عدم الحكم بدون الالتفات إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرتموها
وعن الثالث أنا لا نسلم أن ظن إسناد عدم الحكم إلى وجود المانع يتوقف على العلم بوجود المقتضى عرفا ألا ترى أنا إذا علمنا وجود سبع في الطريق فهذا القدر يكفى في حصول ظن أنه لا
يحضر وإن كان لا يخطر ببالنا في ذلك الوقت سلامة أعضائه بل نجعل ذلك القدر دليلا لنا ابتداءا فنقول مجرد النظر إلى المانع يفيد ظن عدم الحكم الحكم عرفا فليفده شرعا للحديث
وعن الرابع أن ترادف الدلائل والمعرفات على الشيء الواحد لا نسلم أنه خلاف الأصل
فرع لو سلمنا أن التعليل بالمانع يتوقف على وجود المقتضى لكن لا حاجة إلى
ذكر دليل منفصل على وجود المقتضى بل يكفي أن يقال إما أن لا يكون المقتضى موجودا في الفرع وحينئذ يلزم عدم الحكم في الفرع أو قد حصل المقتضى في الفرع لكنه إنما ثبت فيه تحصيلا لمصلحته ودفعا لحاجته وهذا المعنى قائم في الأصل فيلزم ثبوت المقتضى في الأصل
وإذا ثبت ذلك فقد صح جواز تعليل عدم الحكم فيه بالمانع
المسألة الخامسة عشر
قال بعضهم وجود الوصف الذي يجعل علة في الأصل لابد وأن يكون متفقا عليهوهذا ضعيف لأنه لما أمكن إثباته بالدليل حصل الغرض بل الحق أن ذلك قد يكون معلوما بالضرورة وقد يكون معلوما بالبرهان اليقينى وقد يكون معلوما بالأمارة الظنية وهذا آخر الكلام في العلة