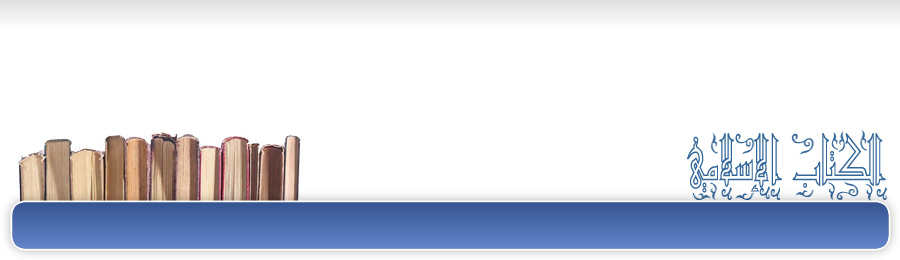كتاب : المحصول في علم الأصول
المؤلف : محمد بن عمر بن الحسين الرازي
عن الباطل
قلنا لا نسلم أن ذلك النهي خطاب مع الكل بل خطاب مع كل واحد منهم والفرق بين الكل وبين كل واحد منهم معلوم ونحن إنما ندعي عصمة الكل لا عصمة كل واحد
سلمنا كونه خطابا للكل لكن النهي لا يقتضي إمكان المنهى عنه من من ! كل وجه لأن الله عز و جل ينهى المؤمن عن الكفر مع علمه بأنه لا يفعله وما علم أنه لا يوجد فهو محال الوجود
وأما حديث معاذ فهو إنما ترك ذكر الإجماع لأنه لا يكون حجة في زمان حياة الرسول صلى الله عليه و سلم
و أما قوله صلى الله عليه و سلم لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي فهو يدل على حصول الشرار في
ذلك الوقت فأما أن يكونوا بأسرهم شرارا فلا وكذا القول في سائر الحديث
و أما قوله صلى الله عليه و سلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ففي صحته كلام
سلمناه لكن لعلة خطاب مع قوم مخصوصين
قوله جاز الخطأ على كل واحد فيجوز على الكل
قلنا لا نسلم أن حكم المجموع مساو لحكم الآحاد والمثال الذي ذكره يدل على أن ذلك قد يكون كذلك ولا يدل على أنه لابد وأن يكون كذلك
سلمنا أن حكم المجموع مساو لحكم الآحاد ولكن عندنا يجوز الخطأ على الكل أيضا لكن ليس كل ما جاز وقع والله تعالى
لما أخبر عنهم أن ذلك لا يقع علمنا أنهم لا يتفقون على الخطأ
قوله اتفاقهم إما أن يكون لدلالة أو لأمارة
قلنا لم لا يجوز أن يكون لدلالة إلا أنهم ما نقلوها اكتفاء منهم بالإجماع فإنه متى حصل الدليل الواحد كان الثاني غير محتاج إليه والله أعلم
المسلك الثاني التمسك بقوله عز و جل وكذلك جعلناكم أمه وسطا لتكونوا شهداء على الناس الله تعالى أخبر عن كون هذه الأمة وسطا والوسط من كل شيء خياره فيكون الله عز و جل قد أخبر عن خيرية هذه الأمة فلو أقدموا
على شيء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على شيء من المحظورات وجب أن يكون قولهم حجة
فإن قيل الآية متروكة الظاهر لأن وصف الأمة بالعدالة يقتضي اتصاف كل واحد منهم بها وخلاف ذلك معلوم بالضرورة فلا بد من حملها على البعض ونحن نحملها على الأئمة المعصومين
سلمنا أنها ليست متروكة الظاهر لكن لا نسلم أن الوسط من كل شيء خياره و يدل عليه وجهان
الأول أن عدالة الرجل عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المحرمات وهذا من فعل الرجل وقد أخبر الله تعالى أنه جعلهم وسطا
فاقتضى ذلك أن كونهم وسطا من فعله تعالى وذلك يقتضي
أن يكون ذلك غير عدالتهم التي ليست من فعل الله تعالى
الثاني أن الوسط اسم لما يكون متوسطا بين شيئين فجعله حقيقة في العدل يقتضي الاشتراك وهو خلاف الأصل
سلمنا أن الوسط من كل شيء خياره فلم قلتم أن خبر الله تعالى عن خيرية قوم يقتضي اجتنابهم عن كل المحظورات ولم لا يجوز أن يقال إنه يكفي فيه اجتنباهم عن الكبائر فأما عن الصغائر فلا
وإذا كان كذلك فيحتمل أن الذي أجمعوا عليه وإن كان خطأ لكنه من الصغائر فلا يقدح ذلك في خيريتهم
ومما يؤكد هذا الاحتمال أنه تعالى حكم بكونهم عدولا ليكونوا شهداء على الناس وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة
سلمنا اجتنابهم عن الصغائر والكبائر ولكن الله تعالى بين
أن أتصافهم بذلك إنما كان لكونهم شهداء على الناس ومعلوم أن هذه الشهادة إنما تكون في الآخرة فيلزم وجوب تحقق عدالتهم هناك لأن عدالة الشهود إنما تعتبر حالة الأداء لا حالة التحمل وذلك مما لا نزاع فيه لأن الأمة تصير معصومة في الآخرة فلم قلتم إنهم في الدنيا كذلك
سلمنا وجوب كونهم عدولا في الدنيا لكن المخاطبين بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الآية لأن الخطاب مع من لم يوجد بعد محال
وإذا كان كذلك فهذا يقتضي عدالة أولئك الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت ولا يقتضي عدالة غيرهم
فهذه الآية تدل على أن إجماع أولئك حق فيجب أن لا نتمسك بالإجماع إلا إذا علمنا حصول قول كل أولئك فيه لكن ذلك يقضي حصول العلم بأعيانهم والعلم ببقاءهم إلى
ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم ولما كان ذلك مفقودا تعذر التمسك بشيء من الإجماعات
والجواب
قوله الآية متروكة الظاهر
قلنا لا نسلم
قوله لأنها تقتضي كون كل واحد منهم عدلا
قلنا لما ثبت أنه لا يجوز إجراؤها على الظاهر وجب أن يكون المراد منه امتناع خلو هذه الأمة من ! العدول
قوله تحمله على الإمام المعصوم
قلنا قوله وكذلك جعلناكم أمه وسطا صيغة جمع فحمله على الواحد خلاف الظاهر
قوله لم قلت إن الوسط في كل شيء خياره
قلنا للآية والخبر والشعر والنقل والمعنى
أما الآية فقوله عز و جل قال أوسطهم أي أعدلهم
وأما الخبر فقوله صلى الله عليه و سلم خير الأمور أوسطها أي أعدلها
وقيل كان النبي صلى الله عليه و سلم أوسط قريش نسبا وقال عليه السلام عليكم بالنمط الأوسط
وأما الشعر فقوله
... هموا وسط يرضى الأنام بحكمهم
وأما النقل فقال الجوهري في الصحاح وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا
وأما المعني فلأن الوسط حقيقة في البعد عن الطرفين فالشيء الذي يكون بعيدا عن طرفي الإفراط والتفريط الذين هما رديان كان متوسطا فكان فضيلة ولهذا سمي الفاضل في كل شيء وسطا
قوله عدالتهم من فعلهم لا من فعل الله تعالى
قلنا هذا ممنوع على مذهبنا
قوله لم قلت إن إخبار الله تعالى عن عدالتهم يقتضي اجتنابهم عن الصغائر
قلنا من الناس من قال لا صغير على الإطلاق بل كل ذنب فهو صغير بالنسبة إلى ما فوقه كبير بالنسبة إلى ما تحته فسقط عنه هذا السؤال
وأما من اعترف بذلك فجوابه أن الله تعالى عالم بالباطن والظاهر فلا يجوز أن يحكم بعدالة أحد وصحة شهادته إلا والمخبر عنه مطابق للخبر فلما أطلق الله تعالى القول بعدالتهم وجب أن يكونوا عدولا في كل شيء بخلاف شهود الحاكم حيث تجوز شهادتهم وأن جاز عليهم الصغائر لأنه لا سبيل للحاكم إلى معرفة الباطن فلا جرم اكتفى بالظاهر
قوله الغرض من هذه العدالة أداء الشهادة في الآخرة
وذلك يوجب عدالتهم في الآخرة لا في الدنيا
قلنا لو كان المراد صيرورتهم عدولا في الآخرة لقال سنجعلكم أمة وسطا
ولأن جميع الأمم عدول في الآخرة فلا يبقى في الآية تخصيص لأمة محمد صلى الله عليه و سلم بهذه الفضيلة
قوله المخاطب بهذ الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الآية
قلنا مر الجواب عن مثل هذا السؤال في المسلك الأول والله أعلم وأحكم
المسلك الثالث
قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولام الجنس تقتضي الاستغراق فدل على أنهم أمروا بكل معروف ونهوا عن كل
منكر فلو أجمعوا على خطأ قولا لكان قد أجمعوا على منكر قولا ولو كانوا كذلك لكانوا آمرين بالمنكر ناهين عن المعروف وهو يناقض مدلول الآية
فإن قيل الآية متروكة الظاهر لأن قوله كنتم خير أمة خطاب معهم وهو يقتضي اتصاف كل واحد منهم بهذا الوصف والمعلوم خلافة
فثبت أنه لا يمكن إجراؤها على ظاهرها فنحملها على أن المراد من الأمة بعضهم وعندنا أن ذلك البعض هو الإمام المعصوم
سلمنا أنه يمكن إجراء الآية على ظاهرها لكن لا نسلم أنهم كانوا يأمرون بكل معروف لما مر في باب العموم أن المفرد المعرف لا يفيد الاستغراق
سلمنا العموم لكن الآية تقتضي اتصافهم بالأمر بالمعروف في الماضي أو الحاضر
الأول مسلم والثاني ممنوع فلم قلتم بأنهم بقوا على هذه الصفة في الحال
فإن قلت لأن هذه الآية خرجت مخرج المدح لهم في الحال ولا يجوز أن يمدح إنسان في الحال بما فعله من قبل إذا عدل عنه إلى ضده فإن الناهي عن المنكر إذا صار آمرا به استحق الذم
قلت لا نسلم أن هذه الآية خرجت مخرج المدح ولم لا يجوز أن يقال ليس فيها إلا بيان أن هذه الأمة كانوا قبل ذلك خيرا من سائر الأمم ومجرد الإخبار لا يقتضي المدح
سلمنا دلالتها على المدح لكن لم لا يجوز أن يدمح الإنسان
في الحال بما صدر عنه في الماضي وإن كان يستحق الذم في الحال بما صدر عنه في الحال فإن عندنا الجمع بين استحقاق الذم والمدح غير ممتنع على ما ثبت في مسألة الاحتياط
سلمنا دلالة الآية على حصول هذا الوصف في الحال لكن قوله عز و جل كنتم خير أمة صريح في أن هذا الوصف إنما حصل لهم في الزمان الماضي ومفهومه يدل على عدم حصوله في الحال
سلمنا دلالة الآية على اتصافهم بتلك الصفة في الحال ف لم لا يجوز خروجهم عنها بعد ذلك فإنه لا نزاع في أنه يحسن مدح الإنسان بما له من الصفات في الحال وإن كان يعلم زوالها في المستقبل
فإن قلت ف يلزم أن يكون إجماعهم حجة في ذلك الزمان قلت هب أنه كذلك لكنا لا نقطع على شيء من الإجماعات
بإنه حصل في ذلك الزمان واذا وقع الشك في الكل خرج الكل عن كونه حجة
سلمنا اتصافهم بهذا الوصف في الماضي والحال والمستقبل لكن الآية خطاب مع الموجودين في ذلك الوقت فيكون إجماعهم حجة أما إجماع غيرهم فلا يكون حجة على ما مر من تقرير هذا السؤال في المسلكين الأولين
والجواب
قوله الآية متروكة الظاهر
قلنا لا نسلم
قوله لأنها تقتضي أن يكون كل واحد منهم آمرا بالمروف
وليس كذلك
قلنا المخاطب بقوله تعالى كنتم خير أمة ليس كل واحد من الأمة
أما أولا فلأنه تعالى وصف المخاطب بهذا الخطاب بكونه خير أمة فلو كان المخاطب بهذا الخطاب كل واحد من الأمة لزم وصف كل واحد من الأمة بأنه خير أمة وذلك غير جائز لأن الشخص الواحد لا يوصف بأنه أمه إلا على سبيل المجاز كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة بدليل
أن المتبادر إلى الفهم من قوله حكمت الأمة بكذا المجموع
و أما ثانيا فلأنه يلزم في كل واحد أن يكون خير أمة أخرجت للناس وإن كان كل واحد خير أمة وجب أن يكون كل واحد خيرا من صاحبه ولما بطل ذلك ثبت أن المجموع هو المخاطب بهذ الخطاب وهو يجري مجرى قول الملك لعسكره أنتم خير عسكر في الدينا تفتحون القلاع
وتكسرون الجيوش فإن هذا الكلام لا يفهم منه أن الملك وصف كل واحد من آحاد العسكر بذلك بل إنه وصف المجموع بذلك بمعنى أن في العسكر من هو كذلك فكذا ها هنا وصف الله تعالى مجموع الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى أن منهم من هو كذلك وحمله على الإمام المعصوم غير جائز لأنه واحد ولفظ الأمة لفظ الجمع
قوله المفرد المعرف لا يفيد الاستغراق
قلنا كثير من الناس ذهب إلى أنه يقتضيه
وأيضا فلفظ المعرف لو لم نحمله على الاستغراق لوجب حمله على الماهية ويكفي في العمل به ثبوته في صورة واحدة فيكون معناه أنهم أمروا بمعروف واحد ونهوا عن منكر واحد وهذا القدر حاصل في سائر الأمم لأن كل واحد منهم
قد كان آمرا بمعروف واحد وهو الدين الذي قبله وناهيا عن منكر واحد وهو الكفر الذي رده
وحينئذ لا يثبت بذلك كون هذه الأمة خيرا من سائر الأمم لكن الله تعالى ذكره لبيان ذلك الحكم فعلمنا أنه وجب حمله على الاستغراق تحصيلا للغرض فإنا لو لم نحمله على الاستغراق ولا نحمله على الماهية كان ذلك مخالفا للغة
قوله الآية تقتضي الاتصاف بهذا الوصف في الماضي أو الحاضر قلنا بل في الحاضر لأن قوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لا يتناول الماضي
قولة لفظة كنتم تدل على الماضي
قلنا لا نسلم ل أن قوله كنتم إما أن تكون ناقصة أو زائدة أو تامة فإن كنت ناقصة فنقول إنه وان أفاد تقدم كونهم كذلك لكن قوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
يقتضي كونهم كذلك في المستقبل ودلالة قوله تعالى كنتم على تقدم هذا الوصف لا يمنع من حصوله في المستقبل فتبقى دلالة قوله تأمرون بالمعروف على كونهم كذلك في المستقبل سليمة عن المعارض
وأما الوجهان الآخران فالاستدلال معهما ظاهر
قوله لم قلت إنهم يكونون في الزمان المستقبل كذلك
على هذه الصفة
قلنا لأن صيغة المضارع بالنسبة إلى الحال والاستقبال كاللفظ العام فوجب تناولها لهما معا
قوله هذه الآية خطاب مع الحاضرين
قلنا مر الجواب عنه في المسلك الأول والله أعلم
المسلك الرابع التمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أن أمته لا تجتمع على خطأ والكلام ها هنا يقع في موضعين
أحدهما
إثبات متن الخبر
والثاني
كيفية الاستدلال به
أما الأول فللناس فيه طرق ثلاثة
الفريق الأول ادعاء الضرورة في تواتر معنى هذا الخبر قالوا لأنه نقل هذا المعنى بألفاظ مختلفة بلغت حد التواتر
الأول روي عنه عليه الصلاة و السلام انه قال أمتي لا تجتمع على خطأ
الثاني ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
الثالث لا تجتمع أمتي على ضلالة
الرابع يد الله على الجماعة رواه ابن عمر رضي الله عنهما
الخامس سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على الضلالة فأعطيتها
السادس لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة وروى ولا على خطأ
وروي عن الحسن البصري
وابن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الخبر
وكان الحسن يقول إذا حدثني أربعة من الصحابة تركتهم وقلت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا الخبر من مراسليه
السابع عليكم بالسواد الأعظم وذلك جماعة الأمة لأن كل من دونهم فالأمة بأسرها أعظم منه
الثامن أبو سعيد مرفوعا يد الله على الجماعة ولا نبالي بشذوذ من شذ
التاسع من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه
العاشر من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية
الحادي عشر أبو أمامة مرفوعا لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم
الثاني عشر عمران بن الحصين مرفوعا لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يقاتلها الدجال
الثالث عشر قام ابن عمر في الناس خطيبا وقال إن نبي الله صلى الله عليه و سلم كان يقول لا تزال طائفة
من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله
الرابع عشر ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم رواه جبير بن مطعم وجابر
الخامس عشر من سره أن يسكن بحبوحه الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد خطب به رسول الله صلى الله عليه و سلم وخطب به أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم
السادس عشر لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناوأهم إلى يوم القيامة
السابع عشر ثوبان مرفوعا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله
الثامن عشر أنس وقوم آخرون عنه عليه الصلاة و السلام ستفترق أمتي كذا وكذا فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قيل ومن تلك الفرقة قال هي الجماعة
وهذه الأخبار كلها مشتركة في الدلالة على معنى واحد وهو أن الأمة بأسرها لا تتفق على الخطأ وإذا اشتركت الأخبار الكثيرة في الدلالة على شيء واحد ثم إن كل واحد من تلك الأخبار يرويه جمع كثير صار ذلك المعنى مرويا بالتواتر من جهة المعنى
الطريق الثاني الاستدلال وهو من وجهين
أحدهما
أن هذه الأخبار لو صحت لثبت بها أصل عظيم مقدم على الكتاب والسنة وما هذا شأنه كانت الدواعي متوفرة على البحث عنه بأقصى الوجوه
أما الأولياء فلتصحح هذا الأصل العظيم بها
وأما الأعداء فلدفع مثل هذا الأصل العظيم
فلو كان في متنها خلل لاستحال ذهولهم عنه مع شدة بحثهم عنه وطلبهم له فلما لم يقدر أحد على الطعن فيها علمنا صحتها
وثانيهما
أنه قد ظهر من التابعين إجماعهم على أن الإجماع حجة وظهر منهم استدلالهم على ذلك بهذه الأخبار والاستقراء دل على أن أمتنا لا يجمعون على موجب خبر لأجل ذلك الخبر إلا ويكونون قاطعين بصحة ذلك الخبر فهذا يدل على قطعهم بصحة هذا الخبر
الطريق الثالث أنا نسلم أن هذه الأخبار من باب الآحاد وندعي الظن بصحتها وذلك مما لا يمكن النزاع فيه
ثم نقول إنها تدل على أن الإجماع حجة فيحصل حينئذ ظن أن الإجماع حجة
وإذا كان كذلك وجب العمل به لأن دفع الضرر المظنون واجب
وهذا الطريق أجود الطرق
فنقول أما الطريق الأول وهو ادعاء التواتر فبعيد فإنا لا نسلم بلوغ مجموع هذه الأخبار إلى حد التواتر لأن العشرين بل الآلف لا يكون متواترا لأنه ليس يستبعد في العرف إقدام عشرين إنسانا علي الكذب في واقعة معينة بعبارات مختلفة
وبالجملة فهم مطالبون بإقامة الدلالة على أن مجموع هذه الروايات يستحيل صدوره عن الكذب
سلمنا حصول القطع بهذه الأخبار في الجملة لكنكم إما أن تدعوا القطع بلفظها أو بمعناها
أما القطع بلفظها فهو أن يقال إنا وإن جوزنا في كل واحد
من هذه الأحاديث أن يكون كذبا إلا أنا نقطع بأن مجموعها يستحيل أن يكون كذبا بل لا بد أن يكون بعضها صحيحا
وأما القطع بمعناها فهو أن يقال إن هذه الألفاظ على اختلافهما مشتركة في إفادة معنى واحد فذلك المشترك يصير مرويا بكل هذه الألفاظ فيصير ذلك المشترك منقولا بالتواتر
فنقول إن أردتم الأول فهو مسلم لكن المقصود لا يتم إلا إذا بينتم أن كل واحد من هذه الألفاظ يدل على أن الإجماع حجة دلالة قاطعة إذ لو وجد فيها ما يدل على المطلوب لا على هذا الوجه لم يحصل الغرض لأن الذي ثبت عندكم ليس إلا صحه أحد هذه الأخبار فيحتمل أن يكون الصحيح هو ذلك الخبر الذي لا يدل دلالة قاطعة على حقية الإجماع لكنا نرى المستدلين بهذه الأخبار بعد
فراغهم من تصحيح المتن يتمسكون بواحد منها على التعيين كقوله عليه الصلاة و السلام لا تجتمع أمتي على خطأ ويبالغون فيه سؤالا وجوابا ومعلوم أنه باطل
وأما إن أردتم الثاني فنقول ذلك المعنى المشترك بين الأخبار إما أن يكون هو أن الإجماع حجة أو معنى يلزم منه كون الإجماع حجة
فإن كان الأول فقد ادعيتم أنه نقل نقلا متواترا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الإجماع حجة ومعلوم أن ذلك باطل وإلا لكان العلم بكون الإجماع حجة جاريا مجرى العلم بغزوة بدر وأحد ولما وقع الخلاف فيه وأيضا
فإنا نراكم بعد الفراغ من تصحيح متن هذه الأخبار تتمسكون بلفظ خبر واحد وتوردون عليه الأسئلة والأجوبة
ولو كان ذلك منقولا على سبيل التواتر لكان ذلك الاستدلال عبثا
وبهذا يظهر الفرق بين علمنا بشجاعة علي وسخاوة حاتم بسبب الأخبار المتفرقة وبين هذه المسألة فإنا بعد سماع تلك الأخبار المتفرقة لا نحتاج إلى الاستدلال ببعض تلك الأخبار على شجاعة علي بل يحصل العلم الضروري بذلك
أما ها هنا فقد سلمتم أن بعد سماع هذه الأخبار نفتقر إلى الاستدلال ببعضها على هذا المطلوب فعلمنا أن كون الإجماع حجة ليس جزءا من مفهوم هذه الألفاظ
وإن ادعتيم أن هذه الأخبار دالة على معنى مشترك بين كلها وذلك المعنى يقتضي كون الإجماع حجة فلا بد من الإشارة إلى ذلك المعنى ثم من إقامة الدليل على أنه يلزم من ذلك المشترك كون الإجماع حجة وأنتم ما فعلتم ذلك
فإن قلت القدر المشترك بين هذه الأخبار تعظيم أمر هذه الأمة وبعدها عن الخطأ وما يجري هذا المجرى
قلت تدعون التواتر في مطلق التعظيم أو في تعظيم ينافي إقدامهم على الخطأ في شيء ما
الأول مسلم ولا يفيد الغرض
والثاني إدعاء للتواتر في نفس كون الإجماع حجة وقد تقدم إبطاله
و أما الطريق الثاني وهو الاستدلال فضعيف
قوله لو كانت هذه الأحاديث ضعيفة لطعنوا فيها
قلت وقد طعنوا فيها بأنها من الآحاد
فإن قلت إن أحدا من الصحابة والتابعين لم يقل إنها من الآحاد بل اتفقوا على أنها متواترة
سلمنا أنهم طعنوا فيها من هذا الوجه لكن كان يجب أن يطعنوا فيها على سبيل التفصيل
قلت الجواب عن الأول
إن النقل عن المؤمنين أنهم جعلوها من باب التواتر ثبت بالتواتر أو بالآحاد
الأول يقتضي كونها متواترة عندنا لأنه متى كان الخبر متواترا وصح عندكم بالتواتر كونها متواترة عندهم لزم كونها متواترة عندكم لكنكم في هذا المقام سلمتم أنها ليست كذلك
والثاني
يقتضي أن تكون هذه الأخبار من الآحاد لأن كونها متواترة عن الصحابة والتابعين لما لم يثبت عندنا إلا بالآحاد كانت عندنا من باب الآحاد لأن استواء الطرفين والواسطة معتبر في التواتر
وعن الثاني أن نقول ليس كل من لا يعلم صحته وجب أن يعلم فساده فالصحابة والتابعون ما عرفوا صحة هذه الأخبار ولا فسادها بل ظنوا صحتها فلا يجب عليهم في هذه الحالة أن يطعنوا فيها على سبيل التفصيل
و أما الوجه الثاني في الاستدلال وهو قوله الصحابة والتابعون اجمعوا على صحة الإجماع وانما اجمعوا على صحته لهذا الأخبار وعادة امتنا انهم لا يجمعون على موجب خبر لأجل ذلك الخبر الا وكان الخبر مقطوعا به
قلنا المقدمات الثلاثة ممنوعة فلا نسلم إجماع الصحابة والتابعين على صحة الإجماع
سلمناه لكن لا نسلم أنهم إنما ذهبوا إلى ذلك لأجل هذه الأخبار بل إنما قالوا به لأجل الآيات
فإن ادعوا التواتر في هذين المقامين كان ذلك مكابرة فإن تلك الأخبار أظهر بكثير من ادعاء هذين المقامين ولما لم يدعوا التواتر في تلك الأخبار فلأن لا يجوز ادعاؤه في هذين المقامين كان أولى
سلمنا هما لكن لا نسلم أن عادتهم جارية بأنهم لا يجمعون على موجب خبر لأجل ذلك الخبر إلا وقد قطعوا بصحته ألا ترى أن الصحابة أجمعوا على حكم المجوس بخبر عبد الرحمن وأجمعوا على أن المرأة لا تنكح على عمتها
ولا خالتها بخبر واحد
وبالجملة فهم مطالبون بالدلالة على هذه العادة التي ادعوها فثبت بما ذكرنا ضعف هذه الوجوه وثبت أن الصحيح هو الطريق الثالث وهو أن نجعلها من أخبار الآحاد
وعلى هذا لا نحتاج إلى تكثيرها بل كل واحد منها يكفي في الاستدلال
المقام الثاني في كيفية الاستدلال التمسك بقوله صلى الله عليه و سلم لا تجتمع أمتي على خطأ
فإن قيل إن كان المراد بقوله أمتي كل من يؤمن به إلى يوم القيامة خرج الإجماع عن كونه حجة
وإن كان المراد به الموجودين وقت نزول ذلك الخبر دل ذلك على أن إجماعهم حجة لكنا إنما نعرف إجماعهم إذا عرفناهم بأعيانهم وعرفنا بقاءهم إلى ما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم وذلك غير معلوم فحينئذ يخرج الإجماع عن كونه حجة
سلمنا أن المراد بالأمة أهل كل عصر لكن لم قلت إن هذه اللفظة تدل على نفي الخطأ عنهم لاحتمال أن قوله لا تجتمع أمتي على خطأ جاء بسكون العين على أن يكون ذلك نهيا منه صلى الله عليه و سلم لأمته عن أن يجتمعوا على خطأ فاشتبه ذلك على الراوي فنقله مرفوعا على أن يكون خبرا
سلمنا كونه خبرا لكن لم قلت إنه يدل على نفي
الخطأ بأسره عنهم ولا نسلم أن النكرة في النفي تعم
وإذا كان كذلك فإما أن نحمله على نفي السهو أن نفي الكفر جمعا بينه وبين الحديث المروي في هذا الباب وهو قوله صلى الله عليه و سلم أمتي لا تجتمع على ضلالة
سلمنا كون الأمة مصيبين في كل أقوالهم وأفعالهم فلم لا يجوز مخالفتهم فإن المجتهد قد يكون مصيبا مع أن المجتهد الآخر يكون متمكنا من مخالفته و الجواب
أما السؤال الأول فمدفوع بسائر الأحاديث الواردة في هذا الباب وهي قوله صلى الله عليه و سلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وقوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقوله من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه
قوله لعل هذا الحديث ورد على صيغة النهي
قلنا عدالة الراوي تفيد ظن صحة تلك الرواية
ومطلوبنا ها هنا الظن وإلا لو فتحنا هذا الباب لا نسد باب الاستدلال بأكثر النصوص
ثم إنه مدفوع بسائر الأحاديث
وأما أن النكرة في النفي تعم فقد تقدم بيانه في باب العموم
قوله نحمله نفي السهو
قلنا اجتماع الجمع العظيم على عدم السهو ممتنع ف لا يمكن ذكره في معرض التعظيم ولأنه لا يكون في تخصيص أمته بذلك فضيلة
قوله نحمله على نفي الكفر كقوله صلى الله عليه و سلم لا تجتمع أمتي على ضلالة
قلنا كل حديث مستقل بنفسه ولأن الضلال لا يقتضي الكفر قال الله تعالى ووجدك ضالا فهدى وقال فعلتها إذن وأنا من الضالين
قوله هب أن الأمة مصيبون في إجماعهم فلم لا تجوز مخالفتهم
قلت لأن الأمة على قولين منهم من قال إن الإجماع حجة لا تجوز مخالفته
ومنهم من قال إنه ليس بحجة فلو قلنا إنه حجة تجوز مخالفتها لكان قولا خارجا عن أقول الأمة فلو كان الحق ذلك لكانت الأمة متفقين على الخطأ وذلك باطل بالحديث
المسلك الخامس دليل العقل
وهو الذي عول عليه إمام الحرمين رحمه الله فقال إجماع الخلق العظيم على الحكم الواحد يستحيل أن يكون إلا لدلالة أو أمارة
فإن كان لدلالة فقد كشف الإجماع عن وجود تلك الدلالة فيكون خلاف الإجماع خلافا لتلك الدلالة
وإن كان لأمارة فقد رأينا التابعين قاطعين بالمنع عن مخالفة هذا الإجماع فلولا اطلاعهم على دلالة قاطعة مانعة من مخالفة هذا الإجماع وإلا لاستحال اتفاقهم على المنع من مخالفته
وهذه الدلالة ضعيفة جدا لاحتمال أن يقال إنهم قد اتفقوا على الحكم لا لدلالة ولا لأمارة بل لشبهة وكم
من المبطلين من كثرتهم وتفرقهم في الشرق والغرب قد اتفقت كلمتهم لأجل الشبهة
سلمنا الحصر فلم لا يجوز أن يكون لأمارة تفيد الظن
قوله رأينا الصحابة مجمعين على المنع من مخالفة هذا الإجماع وذلك يدل على اطلاعهم على دليل قاطع مانع من مخالفة هذا الإجماع
قلنا لا نسلم اتفاق الصحابة على ذلك
سلمناه لكنك لما جوزت حصول الإجماع لأجل الأمارة فلعلهم أجمعوا على المنع من مخالفة الإجماع الصادر عن الأمارة لأمارة أخرى
فإن قلت إنهم لا يتعصبون في الإجماع الصادر عن الأمارة وقد تعصبوا في هذا الإجماع فدل على أن هذا الإجماع ما كان عن أمارة
قلت إذا سلمت أنهم لا يتعصبون في الإجماع الصادر عن الأمارة
ف قد بطل قولك إنهم منعوا من مخالفة هذا الإجماع
المسألة الرابعة
أما الشيعة فقد استدلوا على أن الإجماع حجة بأن زمان التكليف لا يخلو عن الإمام المعصوم ومتى كان كذلك كان الإجماع حجة
بيان الأول يتوقف على إثبات أمرين
الأول أنه لا بد من الإمام
و الدليل عليه أن الإمام لطف وكل لطف واجب فالإمام واجب
و إنما قلنا إن الإمام لطف لأنا نعلم أن الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر يمنعهم عن القبائح ويحثهم على الواجبات كان حالهم في الإتيان بالواجب والاجتناب عن القبيح أتم من حالهم إذا لم يكن لهم هذا الرئيس والعلم بذلك بعد استقراء العادة ضروري
وإنما قلنا إن اللطف واجب لوجهين
الأول
أن اللطف كالتمكين في كونه إزاحة لعذر المكلف فإذا كان التمكين واجبا فكذا اللطف
إنما قلنا إن اللطف كالتمكين لأنه يثبت في الشاهد أن أحدنا إذا دعا غيره إلى طعام وكان غرضه نفع ذلك الغير وبقي على ذلك الغرض إلى وقت التناول ولم يبدله وعلم أنه متى تواضع له فإنه يتناول طعامه ومتى لم يفعل ذلك لم يتناوله فإنه تركه التواضع في هذه الحال يجرى مجرى رد الباب عليه والعلم به ضروري
الثاني
أن المكلف لو لم يجب عليه فعل اللطف لم يقبح منه فعل المفسدة أيضا لأنه لا فرق في العقل بين فعل ما يختار المكلف عنده القبيح وبين ترك ما يخل المكلف عنده بالواجب فثبت أن اللطف واجب وثبت أنه لا بد في زمان
التكليف من الإمام
الثاني
أن ذلك الإمام يجب أن يكون معصوما
والدليل عليه أنه إنما احتاج الخلق إلى الإمام لصحة القبيح عليهم فلو تحققت هذه الصحة في الأمام لافتقر الإمام إلى إمام اخر ولزم التسلسل وهو محال
فثبت أنه يجب أن يكون معصوما وثبت أنه لا بد في زمان التكليف من إمام معصوم
وإذا ثبت هذا وجب كون الإجماع حجة لأنه مهما اتفق العلماء على حكم فلا بد وأن يوجد في أثناء قولهم قول ذلك
المعصوم لأنه أحد العلماء بل هو سيدهم وإلا لم يكن ذلك قولا لكل الأمة وقول المعصوم حق
فإذن إجماع الأمة يكشف عن قول المعصوم الذي هو حق فلا جرم قلنا الإجماع حجة
قالوا وظهر بهذا أن العلم بكون الإجماع حجة لا يتوقف على العلم بالنبوة أصلا وأن إجماع كل الأمم حجة كما أن إجماع أمتنا حجة
والسؤال عليه أنا لا نسلم أنه لا بد من إمام ولا نسلم أنه لطف ولا نسلم أن الخلق إذا كان لهم رئيس يمنعهم عن القبائح ويحثهم على الطاعات كانوا أقرب إليها مما إذا لم يكن لهم هذا الرئيس
بيانه أنكم تزعمون إن الله عز و جل ما أخلى العالم قط من رئيس فقولكم وجدنا متى خلا عن الرئيس حصلت المفاسد باطل لأنكم إذا لم تجدوا العالم خاليا عنه قط ف كيف يمكنكم أن تقولوا إنا وجدنا العالم متى خلا عن الإمام حصلت المفاسد بل الذي جربناه أنه متى كان الإمام في الخوف والتقية حصلت المفاسد لكنكم لا توجبون ظهوره وقوته فالذي تريدونه من أن ظهور المفسدة عند عدمه أزيد مما وجدتموه عند خوفه وتستره شيء ما جربتموه
والذي جربتموه وهو ظهور المفسدة عند ضعفه وخوفه فأنتم لا تقولون به فظهر فساد قولكم
سلمنا إمكان هذه التجربة لكنا نقول تدعون اندفاع هذه المفاسد بوجود الرئيس كيف كان أو بوجود الرئيس القاهر
الأول ممنوع فلا بد من الدلالة واستقراء العرف لا يشهد لهم البتة لأن الخلق إنما ينزجرون من السلطان القاهر
فأما السلطان الضعيف فلا بل الشخص الذي لا يرى ولا يعرف ولا يظهر منه في الدنيا أثر ولا خبر فإنه لا يحصل بسببه انزجار عن القبائح ولا رغبة في الطاعات فلم قلتم إن مثل هذا الإمام يكون لطفا
وإن أرددتم الثاني فهو مسلم لكنكم لا توجبونه
فالحاصل أن الذي عرف بالاستقراء كونه لطفا أنتم لا توجبونه والذي توجبونه لا يعرف بالاستقراء كونه لطفا
فإن قلت نحن الآن في إثبات وجوب أصل الإمام فأما البحث عن كيفية فذاك يتعلق بالفضل ونحن الآن لا نتكلم فيه
ثم السبب في تستره ظاهر وهو أن الإمام لو أزيل عنه الخوف لظهر ولزجر الناس عن القبائح ورغبهم في الطاعات فحيث أخافوه كان الذنب من قبلهم
قلت إنكم ادعيتم وجوب نصب الإمام كيف كان سواء كان ظاهرا أو مخفيا ودللتم على وجوبه بكونه لطفا ودللتم على كونه لطفا بتفاوت حال الخلق معه في الطاعات والمعاصي فلا بد من إثبات هذه المقدمة عند وجود الإمام كيف كان الإمام حتى يمكن الاستدلال به على وجود الأمام كيف كان
ونحن نمنع ذلك فإن تمسكتم باستقراء أحوال العالم
قلنا ذلك التفاوت إنما يحصل من الإمام القاهر وأنت محتاج إلى بيان حصول التفاوت من وجود الإمام كيف كان فما لم تشتغلوا بإثبات هذه المقدمة لا يتم دليلكم فأي نفع لكم ها هنا في أن تذكروا السبب في غيبته وخوفه
سلمنا أن نصب الإمام يقتضي تفاوت حال الخلق من الوجه الذي ذكرتموه لكنه متى يجب نصبه إذا خلا عن جميع جهات القبح أو إذا لم يخل
الأول
مسلم ولكن دليلكم لا يتم إلا إذا أقمتم الدلالة على خلوه عن جميع جهات المفسدة وأنتم ما فعلتم ذلك
والثاني
ممنوع لأن بتقدير اشتماله على جهة واحدة من جهات القبح لا يجوز نصبه لأنه يكفي في كون الشيء قبيحا اشتماله على جهة من جهات القبح ولا يكفي في حسنه اشتماله على جهة واحدة من جهات الحسن ما لم يعرف انفكاكه عن كل جهات القبح
فإن قلت ما ذكرته مدفوع من أربعة أوجه
أحدها
أنه لو جاز القدح في كون الإمام لطفا بما ذكرته جاز القدح
في كون معرفة الله تعالى لطفا بذلك لأن الذي يمكننا في بيان أن معرفة الله تعالى لطف هو أنها باعثة على أداء الواجبات والاحتراز عن القبائح العقلية
فأما بيان خلوها عن جميع جهات القبح فمما لو يوجبه أحد فلو قدح هذا في كون الإمامة لطفا لقدح في كونه معرفة الله تعالى لطفا
وثانيها
أن ما ذكرته يفضي إلى تعذر القطع بوجوب شيء على الله تعالى لكونه لطفا لأنه لا شيء يدعى كونه لطفا إلا والاحتمال المذكور قائم فيه
وثالثها
أنه لا دليل على اشتمال الإمامة على جهة قبح وما لا دليل عليه وجب نفيه
ورابعها
أن جهات القبح محصورة وهي كون الفعل كذبا وظلما وجهلا وغيرها من الجهات وهي بأسرها زائلة عن الإمامة فوجب القطع ينفي اشتمالها على جهة من جهات القبح
قلنا
أما الأول فغير لازم لأن هذا الاحتمال الذي ذكرناه في الإمامة إن كان بعينه قائما في المعرفة من غير فرق وجب الجواب عنه في الموضعين ولا يلزم من تعذر الجواب عنه في الصورتين الحكم بسقوطه من غير جواب
وإن حصل الفرق بين الصورتين بطل ما ذكرتموه
ثم إن الفرق أن معرفة الله عز و جل من الألطاف التي يجب علينا فعلها فإذا علمنا اشتمال المعرفة على جهة
مصلحة ولم نعلم اشتمالها على جهة مفسدة غلب على ظننا كونها لطفا والظن في حقنا قائم مقام العلم في اقتضاء العمل فإنه كما يقبح الجلوس تحت الجدار المائل الذي يعلم سقوطه
كذلك يقبح إذا ظن ذلك فلا جرم وجب علينا فعل المعرفة
أما الإمامة فهي من الألطاف التي توجبونها على الله عز و جل ولا يكفي في الإيجاب على الله تعالى ظن كونها لطفا لأنه عز و جل عالم بجميع المعلومات فما لم يثبت خلو الفعل عن جميع جهات القبح لا يمكن إيجابه على الله عز و جل فظهر الفرق
وعن الثاني
أنا لا نقول في فعل معين إنه لطف فيكون واجبا على الله عز و جل لأن الاحتمال المذكور قائم فيه بل نقول الذي يكون لطفا في نفسه فإنه يجب فعله على الله عز و جل وذلك لا يقدح فيه الاحتمال المذكور
وعن الثالث
أن نقول ما المراد من قولك ما لا دليل عليه وجب نفيه إن عنيت به أن ما لا يعلم عليه دليل وجب نفيه فهذا باطل وإلا وجب على العوام نفي أكثر الأشياء لعدم علمهم بأدلتها
وإن عنيت أن ما لا يوجد دليل عليه في نفس الأمر في نفس الأمر ! وجب نفيه فهذا أيضا ممنوع
وبتقدير التسليم لكن لا نسلم أنه لم يوجد عليه دليل فلعله وجد وأنتم لا تعلمونه
فإن قلت سبرت وبحثت فما وجدت
قلت أقم الدلالة على أن عدم الوجدان يدل على عدم الوجود
وعن الرابع
أن صوم أول يوم من شوال لم يشتمل على كونه ظلما وجهلا وكذبا مع أنه قبيح فجوز ها هنا مثله
وبالجملة فالتقسيم الذي يكون حجة هو المنحصر أما غيره فلا
سلمنا أنه لا بد في القدح في كونه لطفا من تعيين جهة المفسدة لكن ها هنا جهتان
أحداهما
أن نصب الإمام يقتضي كون المكلف تاركا للقبيح لا لكونه قبيحا بل للخوف من الإمام
وإما عند عدم الإمام فالمكلف إنما يتركه لقبحه لا للخوف من الإمام
فإن قلت هذا باطل بترتب العقاب على فعل القبيح
فإنه يقتضي أن يكون المكلف تاركا للقبيح لا لقبحه بل للخوف من العقاب
قلت أنا سائل فيكفيني أن أقول لم لا يجوز أن تكون هذه الجهة مفسدة مانعة وعليك الدلالة على أنها ليست كذلك
ولا يلزم من قولنا ترتيب العقاب عليه لا يقتضي هذه الجهة من المفسدة أن يكون نصب الإمام غير مقتض لها لاحتمال أن يكون حال كل واحدة منهما بخلاف حال الآخر
والذي يحقق ذلك أن ترتيب العقاب على فعل القبيح لا يعلم إلا بالشرع فقبل ورود الشرع يجوز أن تكون فيه مفسدة من هذه الجهة فلما ورد الشرع به علمنا أنه لا مفسدة فيه من هذه الجهة لأن الشرع لا يأتي بالمفسدة فنظيره في مسألتنا أن تقولوا يجوز قبل ورود الشرع أن يكون نصب الإمام مفسدة من هذه الجهة فلما ورد الشرع به علمنا أنه لم يكن مفسدة من هذه الجهة لكن على هذا التقدير يصير وجوب
الإمامة شرعيا
وثانيهما
أن يقال فعل الطاعة وترك المعصية عند عدم الإمام أشق منهما عند وجوده فيكون نصب الإمام سببا لنقصان الثواب من هذا الوجه
وبتقدير هذا الاحتمال فلا نسلم أنه يحسن نصب الإمام فضلا عن وجوبه
سلمنا أن الإمام لطف لكن في كل الأزمنة أو في بعضها الأول ممنوع والثاني مسلم
بيانه
أن من الجائز أن يتفق في بعض الأزمنة وجود
قوم يستنكفون عن طاعة الغير ويعلم الله تعالى منهم أنه متى نصب لهم رئيسا قصدوه بالقتل وإثاره الفتن العظيمة وإذا لم ينصب لهم رئيسا فإنهم لا يقدمون على القبائح ولا يتركون الواجبات فيكون نصب الرئيس في ذلك الوقت مفسدة
ثم هذا وإن كان نادرا إلا أنه لا زمان إلا ويجوز أن يكون هو ذلك الزمان النادر
وحينئذ لا يمكن الجزم بوجوب نصب الإمام في شيء من الأزمنة فإن قلت هذا مدفوع من وجهين
الأول
إن الاستنكاف إنما يكون عن الرئيس المعين وليس الكلام
الآن فيه بل في مطلق الرئيس
الثاني
أن هذه مفسدة نادرة والمفاسد الحاصلة عند عدم الإمام غالبة وإذا تعارض الغالب والنادر كان الغالب أولى بالدفع
قلت الجواب عن الأول
أنه كما يتفق الاستنكاف عن طاعة رئيس معين فقد يتفق الاستنكاف عن طاعة مطلق الرئيس
وأيضا
فإذا سلمتم أن الاستنكاف قد يقع عن طاعة الرئيس المعين فيكون نصب ذلك المعين مفسدة ثم إذا لم يمكن تحصيل المطلق إلا في ذلك المعين كما هو قولكم في الإمامة في أشخاص معينين كان ذلك المطلق أيضا مفسدة
وعن الثاني
هب أن الزمان الذي يقع فيه ذلك الاحتمال نادر إلا أن كل
زمان لما احتمل أن يكون هو ذلك النادر لم يمكنا القطع بوجوب نصبه في شيء من الأزمنة
سلمنا أن الإمامة لطف في كل الأزمنة لكنها لطف يقوم غيرها مقامها أو لا يقوم
الأول مسلم ولكن لما قام غيرها مقامها لم يمكن الجزم بوجوبها على التعين
والثاني ممنوع فلا بد من الدلالة عليه
ثم إنا نبين إمكان البدل على الإجمال تبرعا فنقول إنكم توجبون عصمة الإمام ولسيت عصمة الإمام بإمام اخر معصوم وإلا وقع التسلسل
فإذن له شيء سوى الإمام وقع لطفا في الاحتراز عن
القبائح وأداء الواجبات
وإذا ثبت ذلك في الجملة فلم لا يجوز أن يحصل للأمة لطف قائم مقام الإمام وحينئذ لا يكون نصب الإمام واجبا عينا
سلمنا كون الإمام لطفا على التعين لكن في المصالح الدنيوية أو الدينية
الأول مسلم والثاني ممنوع
بيانه
أن ما ذكرتموه من منفعة وجود الأمام ليس إلا في حصول نظام العالم واندفاع الهرج والمرج وذلك كله مصلحة دنيوية وتحصيل الأصلح في الدنيا غير واجب على الله تعالى فما يكون لطفا فيه أولى أن لا يجب
أو في إقامة الصلوات وأخذ الزكوات وذلك كله مصالح شرعية فما يكون لطفا فيه لا يجب وجوده عقلا
وإن ادعيتم كونه لطفا في شيء آخر وراء ذلك فهو ممنوع
فإن قلت الإمام لطف في المصالح الدينية العقلية لأنه إذا زجرهم عن القبائح وأمرهم بالواجبات العقلية مرة بعد أخرى تمرنت نفوسهم عليها وإذا تمرنت نفوسهم عليها تركوا القبائح لقبحها وأتوا بالواجبات لوجه وجوبها وذلك مصلحة دينية
قلت لا نسلم تفاوت حال الخلق بسبب وجود الإمام في هذا المعنى فإن بوجود الإمام ربما وقعت أحوال القلوب على ما ذكرتموه وربما صارت بالضد من ذلك لأنهم إذا أبغضوه بقلوبهم وعاندته نفوسهم ازدادت المفسدة وربما أقدموا على الأفعال والتروك لمحض الخوف منه
وبالجملة فالتفاوت الحاصل في أحوال الخلق إنما يظهر فيما عددناه من المصالح الدنيوية أو فيما عددناه من المصالح الشرعية
فأما فيما تعدونه من المصالح الدينية العقلية فهذا التفاوت ممنوع فيه فإن الاحتمالات متعارضة فيها
سلمنا أنه لطف فلم قلتم إن كل لطف واجب
قوله في الوجه الأول فعل اللطف جار مجرى التمكين
قلنا هذا قياس وقد بينا أنه لا يفيد اليقين
ثم نقول لا نسلم أن فعل اللطف جار مجرى التمكين
قوله من قدم الطعام إلى إنسان وأراد منه تناوله إلى اخره
قلنا لا نسلم أن ترك التواضع في تلك الحالة يقدح في تلك الإرادة على الإطلاق
بيانه أن الإرادات مختلفة فقد يريد الإنسان من غيره أن يتناول طعامه إرادة في الغاية حتى يقرر مع نفسه أنه يفعل كل ما يعلم أن ذلك الضيف لا يتناول طعامه إلا عند فعله
وقد تكون الإرادة لا إلى ذلك الحد كمن يقول أريد أن تأكل طعامي لكن لا إلى حيث أنك لو لم تأكل طعامي إلا
عند تقبيلي رجلك فعلته بل إرادة دون ذلك
إذا لبث هذا فنقول الإرادة إن كانت على الوجه الأول كان ترك التواضع قادحا في تحققها لكن لو كانت على الوجه الثاني لم يلزم من عدم التواضع عدمها
إذا ثبت هذا فنقول لم قلت إن الله عز و جل أراد من المكلفين فعل الطاعات والاجتناب عن القبائح إرادة على الوجه الأول حتى يلزمه فعل اللطف
بيانه أن التكليف تفضل وإحسان والمتفضل لا يجب عليه أن يأتي بجميع مراتب التفضل
قوله في الوجه الثاني إن ترك اللطف كفعل المفسدة قلنا إنه قياس فلا يفيد اليقين لاحتمال أن ما به وقع التغاير يكون شرطا أو مانعا
ثم نقول الفرق أن فعل المفسدة إضرار وترك اللطف ترك للإنفاع وليس يلزم من قبح الإضرار قبح ترك الإنفاع فإنه يقبح منا الإضرار بالغير ولا يقبح ترك إنفاعه
سلمنا أنه يجب فعل اللطف لكن يجب فعل اللطف المحصل أو فعل اللطف المقرب
الأول مسلم والثاني ممنوع فلم قلتم إن الإمام لطف محصل
بيانه أنه لا يمكن القطع بانه عند وجود الإمام يقدم الإنسان على الطاعة ويحترز عن المعصية لا محالة بل الذي يمكن ادعاوه أن الإنسان عند وجود الإمام يكون أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية فيكون الإمام لطفا مقربا
وإذا كان كذلك فلم قلت بوجوبه على الله تعالى وخرج على هذه المسألة مسألة الضيف فإن المضيف إنما يجب عليه التواضع للضيف إذا علم أنه لو تواضع له لأجابه إلى المقصود أو ظن ذلك
فأما إذا علم قطعا أنه لا يجيب به إليه فلا نسلم أنه يحسن منه فعل ذلك التواضع فضلا عن الوجوب
وعلى هذا لا يبعد أن يوجد زمان علم الله أن نصب الإمام في ذلك الزمان لا يكون لهم لطفا محصلا فلم قلت يجب على الله عز و جل نصب الإمام في ذلك الزمان
سلمنا أن اللطف واجب مطلقا لكن متى إذا أمكن فعله أو إذا لم يمكن
الأول مسلم والثاني ممنوع
بيانه إذا علم الله عز و جل أن كل من خلقه في ذلك الزمان فإنه يكون كافرا أو فاسقا فحينئذ لا يكون خلق المعصوم في ذلك الزمان مقدورا له
وإذا كان كذلك فلم قلت إنه لا يحسن التكليف في هذه الحالة وإذا حسن هذا التكليف جوزنا في كل زمان أن يكون هو ذلك الزمان فلا يمكننا القطع بوجوب الإمام في شيء من الأزمنة
وخرج عليه مسألة الضيف فإن هناك إنما يجب عليه التواضع إذا كان ذلك التواضع مقدورا له فأما إذا لم يكن مقدورا له لم يتوقف التماس المضيف تناول الطعام على فعل التواضع بل حسن ذلك الالتماس بدون التواضع
سلمنا كل ما ذكرتموه و لكنه بناء على التحسين والتقبيح العقليين وإنه باطل على ما ثبت في الكتب الكلامية
فهذا هو الاعتراض على مقدمات دليلهم على الترتيب
ثم نقول دليلكم منقوض بصور
إحداها أنه لو كان القضاة والأمراء والجيوش معصومين لكان حال الخلق في الاجتناب عن القبائح أقرب مما إذا لم يكن كذلك
وثانيتها أنه لو وجد في كل بلد امام معصوم
وثالثتها لو كان الإمام عالما بالغيوب و قادرا على التصرف في الشرق والغرب والسماء والأرض
ورابعتها لو كان بحيث لو شاء لاختفى عن الاعين ولطار مع الملائكة فإن خوف المكلفين ها هنا يشتد منه لأن كل أحد يقول لعله معي وإن كنت لا أراه فكان انزجاره عن القبيح أشد
ولا خلاص عن هذه الإلزامات إلا بأحد أمرين
الأول أن يقال إن هذه الأشياء وإن حصلت فيها هذه المنافع لكن علم الله تعالى فيها وجه مفسدة لا نعلمه نحن ولذلك لم يجب على الله تعالى فعلها
الثاني أن يقال إنها وإن كانت خالية عن جميع جهات المفسدة
لكن لا يجب على الله تعالى فعلها
ثم إن كل واحد من هذين الاحتمالين قائم فيما ذكروه فيبطل به أصل دليلهم
سلمنا أنه لا بد من الإمام فلم قلت إنه معصوم قوله ولو لم يكن معصوما لافتقر إلى لطف اخر قلنا نعم لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك اللطف هو الأمة
فإنا قبل قيام الدلالة على أن الإجماع حجة نجوز كونه حجة وذلك التجويز يكفينا في ذلك المقام لأنهم هم المستدلون فيكفينا أن نقول لم لا يجوز أن يكون الإمام لطفا لكل واحد من آحاد الأمة ويكون مجموع الأمة لطفا للإمام فعليهم إقامة الدليل على أنه لا يجوز أن يكون مجموع الأمة معصوما
ومعلوم أنه لا يكفي في ذلك قدحهم في أدلتنا على أن الاجماع حجة
سلمنا كونه معصوما فلم قلت إن الإجماع يشتمل على قوله
وتقريره ما بيناه في أول الباب أن العلم باتفاق كل الناس بحيث يقطع بأنه لم يشد واحد منهم في الشرق والغرب متعذر لا سبيل اليه
سلمنا وجود قوله لكن لا نسلم أن قوله صواب لأن عندهم يجوز أن يفتي الإمام بالكفر والبدعة على سبيل التقية والخوف ويحلف بالله تعالى والأيمان التي لا مخرج منها أن الأمر كذلك
وإذا كان كذلك فلعله لما رأى أهل العالم متفقين على ذلك القول خاف من مخالفتهم فأظهر الموافقة على ذلك الباطل
كيف وعندهم قد أظهر علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع جميع رهط الهاشميين والأمويين والأنصار التقية خوفا من أبي بكر ومن عمر رضي الله عنهما مع قلة أنصارهما وأعوانهما فإذا جاز الخوف والتقية في هذه الصورة فكيف لا يخاف الرجل الواحد جميع أهل العالم عند اتفاقهم على الباطل
سلمنا أنه افتى به عن اعتقاد فلم لا يجوز أن يكون ذلك خطأ من باب الصغائر وعند ذلك يحتاجون إلى إقامة الدلالة على أنه لا تجوز الصغيرة على الأئمة فإن عولوا فيه على حديث التنفير فهو ضعيف لأن العجز الشديد والفتوى بالكفر والفسق وإباحة الدماء والفروج مع الأيمان الغليظة أدخل في باب التنفير من وقوع الصغيرة فإذا جاز أن لا يكون منزها عنه فلم لا يجوز أن لا يكون منزها عن الصغيرة
فهذا ما على هذه الطريقة من الاعتراضات ومن أحاط بها تمكن من القدح في جميع مذاهب الشيعة أصولا وفروعا لأن أصولهم في الإمامة مبنية على هذه القاعدة ومذاهبهم في فروع الشريعة مبنية على التمسك بهذا الإجماع والله أعلم
القسم الثاني فيما أخرج من الاجماع وهو منه
المسألة الأولىكل مسألة فالحكم فيها إما أن يكون بالإيجاب الكلي أو بالسلب الكلي أو بالإيجاب في البعض والسلب في البعض فهذه احتمالات ثلاثة لا مزيد عليها
فإذا اختلف أهل العصر الأول على قولين من هذه الثلاثة فهل لمن بعدهم أن يذكروا الثالث الأكثرون منعوه
وأهل الظاهر جوزوه
والحق أن إحداث القول الثالث إما أن يلزم منه الخروج عما أجمعوا عليه أو لا يلزم
فإن كان الأول لم يجز إحداث القول الثالث
مثاله الأمة اختلفت في الجد مع الأخ على قولين منهم من جعل المال كله للحد
ومنهم من قال إنه يقاسم الأخ
فالقول الثالث وهو صرف المال كله إلى الأخ غير جائز لأن أهل العصر الأول القائلين بالقولين الأولين اتفقوا على أن للجد قسطا من المال فالقول بصرف المال كله إلى الأخ يبطل ذلك
وأما الثاني فإن إحداث القول الثالث فيه جائز لأن المحذور مخالفة الإجماع أو القول بما يلزم منه مخالفته
فأما إذا لم يكن إحداث القول كذلك وجب جوازه واحتج المانعون بأمرين
أحدهما أن الأمة لما اختلفت على قولين فقد أوجب كل واحد من الفريقين الأخذ إما بقوله أو بقول صاحبه
وتجويز القول الثالث يبطل ذلك فإن قلت إنهم إنما أوجبوا ذلك بشرط أن لا يظهر وجه ثالث فإذا ظهر فقد زال شرط ذلك الإجماع
قلت لو جوزنا هذا الاحتمال لجوزنا أن يقال إنما أوجبوا التمسك بالإجماع على القول الواحد بشرط أن لا يظهر وجه القول الثاني فإذا ظهر فقد زال شرط ذلك الإجماع فيجوز الخلاف
وثانيهما أن الذهاب إلى القول الثالث إنما يجوز لو أمكن كونه حقا ولا يمكن كونه حقا إلا عند كون الأولين باطلين ضرورة أن الحق واحد وحينئذ يلزم إجماع الأمة على الباطل
والجواب عن الأول
أن ايجاب الأخذ بأحد ذينك القولين مشروط بأن لا
يظهر الثالث
قوله لو جاز ذلك لجاز مثله في القول الواحد
قلنا إنه جائز لكنهم منعوا من اعتباره فليس لنا أن نتحكم عليهم بوجوب التسوية
وعن الثاني أن هذا الإشكال غير وارد على القول بأن كل مجتهد مصيب فإنه لا يلزم من حقية أحد الأقسام فساد الباقي
وأما على القول بأن المصيب واحد فلا يلزم من التمكن من إظهار القول الثالث كونه حقا لأن المجتهد قد تمكن من العمل بالإجتهاد الخطأ والله أعلم
المسألة الثانية
الأمة إذا لم تفصل بين مسألتين فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما
وأعلم أن هذا يقع على وجهين
أحدهما
أن يقولوا لا فصل بين هاتين المسألتين في كل الأحكام أو في الحكم الفلاني
والآخر
أن لا ينصوا على ذلك لكن ما كان فيهم من فرق بينهما أما القسم الأول فإنه لا يجوز الفصل بينهما ثم إنه على ثلاثة أقسام
أحدها أن تحكم الأمة في المسألتين بحكم واحد إما ب التحليل أو بالتحريم
وثانيها أن يحكم بعض الأمة فيهما بالتحريم والبعض الآخر بالتحليل
وثالثها
ان لا ينقل الينا عنهم حكم فيهما ففي هذه الصورة الثالثة متى دل الدليل في إحدى المسألتين على تحليل أو تحريم وجب أن يكون الحال في الأخرى كذلك
وأما القسم الثاني فقيل فيه إن علم أن طريقة الحكم في المسألتين واحدة فذلك جار مجرى أن يقولوا لا فصل بينهما فمن فصل بينهما فقد خالف ما اعتقدوه
مثاله من ورث العمة ورث الخالة ومن منع إحداهما منع الأخرى
وإنما جمعوا بينهما من حيث انتظمهما حكم ذوي الأرحام فهذا مما لا يسوغ خلافهم فيه بتفريق ما جمعوا بينهما إلا أن هذا الاجماع متأخر عن سائر الإجماعات في القوة
وأما إن لم يكن كذلك فالحق جواز الفرق لمن بعدهم لأنه لا يكون بذلك مخالفا لما أجمعوا عليه لا في حكم ولا في علة حكم
ولأنه لو امتنع الفرق لكان من وافق الشافعي رضي الله عنه في مسألة لدليل وجب عليه أن يوافقه في كل المسائل
احتج المانعون من الفصل مطلقا بوجهين
الأول
أن الأمة إذا قال نصفها بالحرمة في المسألتين و قال
النصف الآخر بالحل فيهما فقد اتفقوا على أنه لا فصل بين المسألتين فيكون الفصل بينهما رد للإجماع
الثاني
أن الأمة إذا اختلفت على قولين في مسألتين فقد أوجبت كل واحدة من الطائفتين على الأخرى أن تقول بقولها أو بقول الطائفة الأخرى وحظرت ما سوى ذلك وذلك يمنع من الفرق بين المسألتين
والجواب عن الأول
إنكم إن عنيتم بقولكم اتفقوا على أنه لا فصل بينهما أنهم نصوا على استوائهما في الحكم أو هما مستويان في علة الحكم فليس كذلك لأن النزاع ليس ها هنا
وإن عنيتم به أن كل من قال بأحدى المسألتين فقد قال
أيضا بالأخرى فلم قلتم إن ذلك يمنع من الفصل فإن هذا أول المسألة
وعن الثاني
أنهم إنما أوجبوا ذلك بشرط أن لا يفرق بعض المجتهدين بين المسألتين فإن أدعوا أنه لا التفات إلى هذا الشرط فهذا عين المتازع فيه
ومن الناس من جوز الفصل مطلقا استدلالا بعمل ابن سيرين في زوج وأبوين أن للام ثلث ما يبقى
وقال في امرأة وأبوين للام ثلث المال فقال في إحداهما بقول ابن عباس وفي الأخرى بقول عامة الصحابة
والثوري قال الجماع ناسيا يفطر والأكل ناسيا لا يفطر وفرق بين المسألتين مع أنه جمعتهما طريقة واحدة والله أعلم
المسألة الثالثة
يجوز حصول الاتفاق بعد الخلاف وقال الصيرفي لا يجوز لنا إجماع الصحابة على إمامة ابي بكر رضى الله عنه بعد
اختلافهم فيها
واتفاق التابعين على المنع من بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه
احتج الخصم بأن أهل العصر الأول اتفقوا على جواز الأخذ بأي القولين كان إذا أدى الاجتهاد إليه فلو أجمعوا على أحد القولين وجب أن يكون الإجماعان صوابا ويكون المتأخر ناسخا للمتقدم لكن ذلك باطل على ما مر في باب النسخ
ولأنه لو جاز ذلك لجاز أن يتفق أهل عصر على قول ويتفق أهل عصر ثان على خلافه
والجواب
أن الإجماع على الأخذ بأي القولين شاء مشروط بعدم الاتفاق فإذا حصل الاتفاق زال شرط الإجماع فزال لزوال شرطه
قوله لو جاز ذلك لجاز مثله عند الاتفاق
قلنا مر الجواب عنه في المسألة الأولى والله أعلم
المسألة الرابعة
إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول كان ذلك اجماعا لا تجوز مخالفته خلافا لكثير من المتكلمين
وكثير من فقهاء الشافعية والحنفية
لنا
أن ما أجمع عليه أهل العصر الثاني سبيل المؤمنين فيجب اتباعه لقوله عز و جل ويتبع غير سبيل المؤمنين
ولأنه إجماع حدث بعد ما لم يكن فيكون حجة كما إذا حدث بعد تردد أهل الإجماع فيه حال التفكر
واعلم أن هذا المقيس عليه ينقض على المخالف أكثر أدلته
احتجوا بأمور
أحدها
قوله عز و جل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أوجب الرد إلى كتاب الله تعالى عند التنازع وهو حاصل لأن حصول الأتفاق في الحال لا ينافي ما تقدم من الاختلاف فوجب فيه الرد إلى كتاب الله تعالى
وثانيها
قوله صلى الله عليه و سلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ظاهره يقتضي جواز الأخذ بقول كل واحد من الصحابة ولم يفصل بين ما يكون بعده إجماع أو لا يكون
وثالثها
أن في ضمن اختلاف أهل العصر الأول الاتفاق على جواز الأخذ بأيهما أريد فلو انعقد إجماع في العصر الثاني لتدافع الإجماعان
ورابعها
لو كان قولهم إذا اتفقوا بعد الاختلاف حجة لكان قول إحدى الطائفتين إذا ماتت الأخرى حجة
وفيه كون قولهم حجة بالموت
وخامسها
لو كان اتفاق أهل العصر الثاني حجة لكانوا قد صاروا إليه لدليل وذلك باطل لأنه لو وجد ذلك الدليل لما خفى على أهل العصر الأول
وسادسها
أن أهل العصر الثاني بعض الأمة فلا يكون اتفاقفهم وحدهم إجماعا
وسابعها
أنه قد ثبت أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث وأهل العصر الأول لما اختلفوا لم يكن القطع بذلك الحكم قولا لواحد منهم فيكون القطع بذلك إحداثا لقول ثالث وإنه غير جائز
وثامنها
أن الصحابة في الحادثة التي اختلفوا فيها كالأحياء ألا ترى
أنه تحفظ في ذلك أقوالهم ويحتج لها وعليها وإذا لم ينعقد الإجماع مع تلك الأقوال حال حياة القائلين بها وجب أيضا أن لا ينعقد حال وفاتهم
وتاسعها
أن هذا الإجماع لو كان حجة لوجب ترك القول الآخر ولكان إذا حكم به حاكم ثم انعقد الإجماع على خلافه وجب نقضه لكونه واقعا على مضادة دليل قاطع لكن ذلك باطل لأن اهل العصر الأول اتفقوا على نفوذ هذا القضاء فنقضه يكون على خلاف الإجماع
الجواب عن الأول
أن التعلق بالإجماع رد إلى الله والرسول ولأن أهل العصر الثانى إذا اتفقوا فهم ليسوا بمتنازعين
فلم يجب عليهم الرد إلى كتاب الله لأن المعلق بالشرط عدم عند عدم شرطه
وعن الثاني
أنه مخصوص بتوقف الصحابة في الحكم حال الاستدلال مع أنه لا يجوز الاقتداء به في ذلك بعد انعقاد الإجماع فوجب تخصيص محل النزاع عنه والجامع ما تقدم
وعن الثالث
ما مر غير مرة أن ذلك الإجماع مشروط ثم إنه منقوض باتفاقهم حال الاستدلال على التوقف وتجويز الأخذ بأي قول ساق الدليل إليه
ولأنكم اذا جوزتم أن لا يكون اتفاق أهل العصر الثاني حجة فلم لا يجوز أن لا يكون اتفاق أهل العصر الأول حجة إذ ليس أحد الاتفاقين أولى من الآخر
وإذا لم يكن الاتفاق الأول حجة لم يلزم من حصول الاتفاق الثاني ما ذكرتموه من المحذور فثبت أن هذه الحجة متناقضة
وعن الرابع
أنا نتبين بموت إحدى الطائفتين أن قول الطائفة الأخرى حجة لاندراج قولهم تحت أدلة الإجماع لا ان الموت نفسه هو الحجة
وعن الخامس
أنه لا يجوز أن يخفى ذلك الدليل على كلهم لكن يجوز خفاوه على بعضهم
عن السادس
أنه لو كان أهل العصر الثاني بعض الأمة لوجب أن لا يكون اتفاقهم الذي لا يكون مسبوقا بالخلاف حجة وهذا يقتضي أن لا يكون الحجة إجماع الصحابة فقط بل إجماع الذين كانوا موجودين عند ظهور أدلة الإجماع
وهذا القائل لا يقول بهذه المذاهب
وعن السابع
أنه لا يجوز إحداث قول ثالث إذا كان الإجماع منعقدا على عدم جوازه مطلقا
أما إذا كان مشروطا بشرط جاز ذلك عند عدم ذلك الشرط
كما ذكرنا أنهم حال الاستدلال مطبقون على جواز التوقف وعدم القطع مع أن ذلك لا ينافي اتفاقهم على القطع بعده
وعن الثامن
قوله أقوال الصحابة باقية بعد وفاتهم إن عنى
بذلك كونها مانعة من انعقاد الإجماع فهذا عين النزاع
وإن عنى به علمنا بأنهم ذكروا هذه الأقول فلم قلت إن ذلك ينفي انعقاد الإجماع
وان عنيتم ثالثا فبينوه
وعن التاسع
أنا لا ننقض ذلك الحكم لأنه صار مقطوعا به في زمان عدم هذا الإجماع ونحن إنما ننقض الحكم الذي حكم به القاضي إذا وقع ذلك الحكم في زمان قيام الدلالة القاطعة على فساده والله أعلم
المسألة الخامسة
أهل العصر إذا انقسموا إلى قسمين ثم مات أحد القسمين صار قول الباقين إجماعا لأن بالموت ظهر اندراج قول ذلك القسم وحده تحت أدلة الإجماع
وكذا القول إذا انقسموا إلى قسمين ثم كفر أحدهما فإنه يصير القول الثاني حجة والله أعلم
المسألة السادسة
أهل العصر إذا اختلفوا على قولين ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين هل يكون ذلك إجماعا
أما من قال بانعقاد الإجماع في المسألتين السابقتين فقوله به ها هنا أولى ونثبت هذه الأولوية من وجهين
احدهما
أن في المسألتين السابقتين لقائل أن يقول المجمعون ليسوا كل الأمة فلا يكون اتفاقهم قولا لكل الأمة فلا يكون حجة
وأما ها هنا فهذه الشبهة زائلة لأن الذين اتفقوا هم
بعينهم الذين اختلفوا فكان المجمعون كل الأمة
وثانيهما
أن في المسألتين السابقتين ما صار القول الثاني مرجوعا عنه أصلا وها هنا صار كذلك
وأما المنكرون لانعقاد الإجماع هناك فقد اختلفوا ها هنا فأما من اعتبر انقراض العصر فإنه جوز ذلك قال لأن الانقراض لما كان شرطا في الإجماع وهم لم ينقرضوا على ذلك الخلاف فلم يحصل الإجماع على جواز الخلاف فلم يكن الاتفاق حاصلا بعد الإجماع على جواز الخلاف
وأما من لم يعتبر الانقراض فقد اختلفوا
فمنهم من أحال وقوعه
ومنهم من جوزه وزعم أنه لا يكون حجة
ومنهم من جعله إجماعا يحرم خلافه وهو المختار
لنا
ما تقدم من أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في الإمامة ثم اتفقوا بعد ذلك عليها
وإذا ثبت وقوعه وجب أن يكون حجة لقوله عز و جل ويتبع غير سبيل المؤمنين والشبه التي يذكرونها ها هنا هي التي مرت والله أعلم
المسألة السابعة
انقراض العصر غير معتبر عندنا في الإجماع خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين منهم الأستاذ أبو بكر بن فورك
لنا
قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وصفهم بالخيرية وإجماعهم لا على الصواب يقدح في وصفهم بالخيرية
وأيضا
فقوله صلى الله عليه و سلم لا تجتمع أمتي على الخطأ ينافي إجماعهم على الخطأ ولو في لحظة واحدة
ومما تمسكوا به في المسألة أنا لو اعتبرنا الانقراض لم ينعقد إجماع لأنه قد حدث من التابعين في زمن الصحابة قوم من أهل الاجتهاد فيجوز لهم مخالفة الصحابة لأن العصر لم ينقرض
ثم الكلام في هذا العصر كالكلام في العصر الأول فوجب أن لا يستقر إجماع أبدا
فإن قلت لم لا يجوز أن يكون المعتبر انقراض عصر من كان مجتهدا عند حدوث الحادثة لا من يتجدد بعد ذلك فلا
يلزم اعتبار عصر التابعين إذا حدث فيهم مجتهد بعد حدوث الحادثة
قلت بتقدير أن يحدث في التابعين واحد من أهل الاجتهاد قبل انقراض عصر من كان مجتهدا عند حدوث الحادثة من الصحابة ففي ذلك الوقت إجماع الصحابة غير منعقد فوجب أن يجوز للتابعي مخالفتهم وكذلك يحدث في تابعي التابعين قبل انقراض عصر من كان مجتهدا من التابعين وهلم جرا إلى زماننا فيلزم أن لا ينعقد الإجماع على ذلك التقدير
ثم إنا نجوز هذا الاحتمال في كل الإجماعات ولا نعلم عدمه فوجب أن لا ينعقد شيء من الإجماعات
و احتج المخالف بأمور
أحدها
أن عليا رضي الله عنه سئل عن بيع أمهات الأولاد فقال قد كان رأيي ورأي عمر أن لا يبعن ثم رأيت بيعهن فقال له عبيدة السلماني رأيك في الجماعة أحب الينا من رأيك وحدك فدل قول عبيدة عن أن الإجماع كان
حاصلا مع أن عليا رضي الله عنه خالفه
وثانيها
أن الصديق كان يرى التسوية في القسم ولم يخالفه أحد في زمانه ثم خالفه عمر بعد ذلك
وثالثها
أن الناس ما داموا في الحياة يكونون في التفحص والتأمل فلا يستقر الاجماع
ورابعها
قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ومذهبكم ! يقتضي أن يكونوا شهداء على أنفسهم أيضا
وخامسها
أن قول المجمعين لا يزيد على قول النبي صلى الله عليه و سلم فإذا كانت وفاة النبي صلى الله عليه و سلم شرطا في استقرار الحجة من قوله فلأن يعتبر ذلك في قول أهل الاجماع أولى
و الجواب عن الأول
أن قول السلماني رأيك في الجماعة دل على أن المنع من بيعهن كان رأي جماعة ولم يدل على أنه كان رأي كل الأمة وإنما أراد أن ينضم قول علي الى قول عمر رضي الله عنهما لأنه رجح قول الأكثر على قول الأقل
وعن الثاني
أنا لا نسلم انعقاد الإجماع على فعل أبي بكر رضي الله عنه بل نقل أن عمر رضي الله عنه نازعه فيه
وعن الثالث
أنهم إن أرادوا بنفي الاستقرار أنه لا يحصل الاتفاق فهو باطل لأن كلامنا في أنه لو حصل لكان حجة
وإن أرادوا به أنه بعد حصوله لا يكون حجة فهو عين النزاع
وعن الرابع
أن كونهم شهداء على الناس لا ينافي شهادتهم على أنفسهم
وعن الخامس
أنه جمع بين الموضعين من غير دليل وبالله التوفيق
المسألة الثامنة
اختلفوا في أنا لو جوزنا انعقاد الإجماع عن السكوت فهل يعتبر فيه الإنقراض
ذهب كثير ممن لم يعتبر الانقراض في الإجماع القولي إلى اعتباره ها هنا لأن سكوته يمكن أن يكون للتفكر في حكم تلك الحادثة
فأما إذا مات عليه علمنا حينئذ أن سكوته
كان رضى
وهذا ضعيف لأن السكوت إن دل على الرضا وجب أن يحصل ذلك قبل الموت
وإن لم يدل عليه لم يحصل ذلك أيضا بالموت لاحتمال أنه مات على ما كان عليه قبل الموت والله أعلم
المسألة التاسعة
الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة خلافا لأكثر الناس
لنا
أن ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون
ولأن الإجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياسا على السنة
ولأنا بينا أن أصل الإجماع قاعدة ظنية فكيف القول في تفاصيله
القسم الثالث
فيما ادخل في الاجماع وليس منهالمسألة الأولى
إذا قال بعض أهل العصر قولا وكان الباقون حاضرين لكنهم سكتوا وما انكروه
فمذهب الشافعي رضي الله عنه وهو الحق أنه ليس بإجماع ولا حجة
و قال الجبائي إنه إجماع وحجة بعد انقراض العصر
وقال أبو هاشم ليس بإجماع ولكنة حجة
وقال أبو علي بن أبي هريرة إن كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعا ولا حجة
وإن لم يكن من حاكم كان إجماعا وحجة
لنا
أن السكوت يحتمل وجوها أخر سوى الرضى وهي ثمانية
أحدها
أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول وقد تظهر عليه قرائن السخط
وثانيها
ربما رآه قولا سائغا أدى اجتهاده إليه وإن لم يكن موافقا عليه
وثالثها
أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب فلا يرى الإنكار فرضا أصلا
ورابعها
ربما أراد الإنكار ولكنه ينتهز فرصة التمكن منه
ولا يرى المبادرة إليه مصلحة
وخامسها
أنه لو أنكر لم يلتفت إليه ولحقه بسبب ذلك ذل كما قال ابن عباس في سكوته عن العول هبته وكان والله مهيبا
وسادسها
ربما كان في مهلة النظر
وسابعها
ربما سكت لظنه أن غيره يقوم مقامه في ذلك الإنكار وإن كان قد غلط فيه
وثامنها
ربما رأى ذلك الخطأ من الصغائر فلم ينكره
وإذا احتمل السكوت هذه الجهات كما احتمل الرضى علمنا أنه لا يدل على الرضا لا قطعا ولا ظاهرا وهذا معنى قول الشافعي رحمه الله لا ينسب الى ساكت قول
و احتج الجبائي
بأن العادة جارية بأن الناس إذا تفكروا في مسألة زمانا طويلا واعتقدوا خلاف ما انتشر من القول أظهروه إذا لم تكن هناك تقية ولو كانت هناك تقية لظهرت واشتهرت فيما بين الناس فلما لم يظهر سبب التقية ولم يظهر الخلاف علمنا حصول الموافقة
وجوابه
ما بينا أن وراء الرضى احتمالات أخرى
واحتج أبو هاشم
بأن الناس في كل عصر يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يعرف له مخالف
وجوابه
أن ذلك ممنوع
واحتج أبو علي بن أبي هريرة
بأن هذا القول إن كان من حاكم لم يدل سكوت الباقين على الإجماع لأن الواحد منا قد يحضر مجالس الحكام فيجدهم يحكمون بخلاف مذهبه وما يعتقده ثم لا ينكر عليهم
وإن كان من غير الحاكم كان إجماعا
وهو ضعيف لأن عدم الإنكار إنما يكون بعد استقرار
المذهب وأما حال الطلب فالخصم لا يسلم جواز السكوت إلا عن الرضى سواء كان مع الحاكم أو مع غيره والله أعلم
المسألة الثانية
اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف والحق أن هذا القول إما أن يكون مما تعم به البلوي أولا يكون
فإن كان الأول ولم ينتشر ذلك القول فيهم فلا بد وأن يكون لهم في تلك المسألة قول إما موافق أو مخالف و لكنه لم يظهر فيجرى ذلك مجرى قول البعض بحضرة الباقين وسكوت الباقين عنه
وإن كان الثاني لم يكن إجماعا ولا حجة لاحتمال ذهول البعض عنه
وبهذا التقدير لا يكون للذاهلين فيه قول فلا يكون الإجماع حاصلا
المسألة الثالثة
إذا استدل أهل العصر بدليل أو ذكروا تأويلا ثم استدل أهل العصر الثاني بدليل آخر أو ذكروا تأويلا آخر فقد
اتفقوا على أنه لا يجوز إبطال التأويل القديم لأنه لو كان ذلك باطلا وكانوا ذاهلين عن التأويل الجديد الذي هو الحق لكانوا مطبقين على الخطأ وهو غير جائز
وأما التأويل الجديد فإن لزم من ثبوته القدح في التأويل القديم لم يصح كما إذا اتفقوا على تفسير اللفظ المشترك بأحد معنييه ثم جاء من بعدهم وفسره بمعناه الثاني لم يجز ذلك لأنا قد دللنا على أن اللفظ الواحد لا يجوز استعماله لإفادة معنييه جميعا فصحة هذا التأويل الجديد تقتضي فساد القديم وإنه غير جائز
أو يقال إنه تعالى تكلم بتلك اللفظه مرتين وهو باطل لانعقاد الإجماع على ضده
و إما اذا لم يلزم من صحة التأويل الجديد فساد التأويل القديم جاز ذلك
والدليل عليه أن الناس يستخرجون في كل عصر أدلة وتأويلات جديدة ولم ينكر عليهم أحد فكان ذلك إجماعا
و للمانع أن يحتج بأمور
أولها
أن الدليل الجديد مغاير لسبيل المؤمنين فوجب أن يكون محظورا لقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين
وثاينها
أن قوله تعالى كنتم خير أمة خطاب مشافهة فلا يتناول إلا أهل العصر الأول
ثم قوله تأمرون بالمعروف يقتضي كونهم آمرين بكل معروف فكل ما لم يأمروا به ولم يذكروه وجب أن لا يكون معروفا فكان منكرا
وثالثها
أن الدليل الثاني والتأويل الثاني لو كان صحيحا لما جاز ذهول الصحابة مع تقدمهم في العلم عنه
والجواب عن الأول
أن قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين خرج مخرج الذم فيختص بمن اتبع ما نفاه المؤمنون لأن ما لم يتكلم فيه المؤمنون بنفي ولا بإثبات لا يقال فيه إنه اتباع لغير سبيل المؤمنين
وأيضا
فالحكم بفساد ذلك الدليل ما كان سبيلا للمؤمين فوجب كونه باطلا
وعن الثاني
أن قوله وتنهون عن المنكر يقتضي نهيهم عن كل المنكرات فكل ما لم ينهوا عنه وجب أن لا يكون منكرا لكنهم ما نهوا عن هذا الدليل الجديد فوجب أن لا يكون منكرا
وعن الثالث
أنه لا استبعاد في أنهم اكتفوا بالدليل الواحد والتأويل الواحد وتركوا طلب الزيادة والله أعلم
المسألة الرابعة
قال مالك اجماع أهل المدينة وحدها حجة
وقال الباقون ليس كذلك
حجة مالك
قوله صلى الله عليه و سلم إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والخطأ خبث
فكان منفيا عنهم
فإن قيل وجد في الخبر ما يقتضي كونه مردودا لأن ظاهره أن كل من خرج عنها فإنه من الخبث الذي تنفيه المدينة وذلك
باطل لأنه قد خرج منها الطيبون كعلي وعبد الله رضي الله عنهما بل ذكروا ثلاثمائة ونيفا من الصحابة الذين انتقلوا إلى العراق وهم أمثل من الذين بقوا فيها كأبي هريرة وأمثاله
سلمنا سلامته عن هذا الطعن لكنه من أخبار الآحاد فلا يجوز التمسك به في مسألة علمية
سلمنا صحة متنه لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك محمولا على من خرج منها لكراهية المقام بها مع أن في المقام
بها بركة عظيمة بسبب جوار الرسول وجوار مسجده صلى الله عليه و سلم و مع ما ورد من الثناء الكثير على المقيمين بها لأن الكاره للمقام بها مع هذه الأحوال لا بد وأن يكون ضعيف الدين ومن كان كذلك فهو خبث
سلمنا أن المراد كونها نافية للقول الباطل لكن قوله لتنفي خبثها ليس فيه صيغة عموم
سلمناه لكن لم لا يجوز تخصيص هذا القول بزمانه ويكون المراد بالخبث الكفار
ثم إنه معارض بأمور ثلاثه
الأول
أن الذي دل على كون الإجماع حجة وارد بلفظين لفظ
المؤمنين في آية المشاقة ولفظ الأمة في غيرها وهاتان اللفظتان غير مخصوصتين ببلدة دون بلدة فوجب اعتبار الكل
الثاني
أن الأماكن لا تؤثر في كون الأقول حجة
الثالث الثالث
أن القول به يودي إلى المحال لأن من كان ساكن المدينة كان قوله حجة فإذا خرج منها لا يكون قوله حجة ومن كان قوله حجة في مكان كان قوله حجة في كل مكان كالرسول صلى الله عليه و سلم
و الجواب
قوله يقتضي أن كل من خرج من المدينة فهو خبث
قلنا لا نسلم لأن الخبر يقتضي أن كل ما كان خبثا
فإن المدينة تخرجه وهذا لا يقتضي أن كل ما تخرجه المدينة فهو خبث
قوله إنه خبر واحد فلا يجوز التمسك به في العلميات قلنا لا نسلم أن هذه المسألة علمية بل لما ثبت بهذا الخبر ظن أن إجماع أهل المدينة حجة والعمل بالظن واجب وجب العمل به
قوله نحمله على من كره المقام بالمدينة
قلنا تقييد المطلق خلاف الأصل ولو جاز ذلك لجاز في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين
و في قوله عليه الصلاة و السلام لا تجتمع أمتي على خطأ حمله على بعض الصور ولما كان جواب الجمهور أن تخصيص العام وتقييد المطلق خلاف الأصل وأنه لا يجوز القول به من غير ضرورة فكذا ها هنا
قوله ليس في قوله لتنفى خبثها صيغة عموم قلنا لا نسلم فإن الحقيقة لا تنتفي إلا عند انتفاء جميع أفرادها فلولا انتفاء جميع أفراد الخبث عن المدينة وإلا لما صح القول بأنها تنفى الخبث
قوله لم لا يجوز تخصيصه بزمانه
قلنا لأن التخصيص خلاف الأصل
قوله الأدلة على أن الإجماع حجة غير مختصة بقوم دون قوم
قلنا تلك الأدلة لا تقتضي أن إجماع أهل المدينة حجة ولكنها لا تبطل ذلك فإذا أثبتناه بدليل منفصل لم يلزمنا محذور
قوله لا أثر للمكان
قلنا لا استبعاد في أن يخص الله تعالى أهل بلدة معينة بالعصمة كما أنه لا استبعاد في أن يخص تعالى أهل زمان معين بالعصمة فإنه تعالى خص أمتنا بالعصمة من بين سائر الأمم بلى العقل لا يدل على ذلك وإنما الرجوع فيه إلى السمع
قوله من كان قوله حجة في مكان كان حجة في كل مكان كالنبي صلى الله عليه و سلم
قلنا هذا قياس طردي في مقابلة النص فكان باطلا والله أعلم
فهذا تقرير قول مالك رحمه الله وليس بمستبعد كما اعتقد هو و جمهور أهل الأصول والله أعلم
المسألة الخامسة
إجماع العترة وحدها ليس بحجة خلافا للزيدية والإمامية
لنا
أن عليا رضي الله عنه خالفه الصحابة في كثير من المسائل ولم يقل لأحد ممن خالفه إن قولي حجة فلا تخالفني
احتجوا بالآية والخبر والمعنى
أما الآية فقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والخطأ رجس فيجب أن يكونوا مطهرين عنه
وأما الخبر فقوله عليه الصلاة و السلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي
وأما المعنى فإن أهل البيت مهبط الوحي والنبي صلى الله عليه و سلم منهم وفيهم فالخطأ عليهم أبعد
والجواب عن الأول
أن ظاهر الآية في أزواجه صلى الله عليه و سلم لأن ما قبلها وما بعدها خطاب معهن لأنه تعالى قال و قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ويجرى هذا المجرى قول الواحد لابنه تعلم وأطعني إنما أريد لك الخير
ومعلوم أن هذ القول لا يتناول إلا ابنه فكذا هاهنا
فإن قلت هذا باطل من وجوه
أحدها
أنه لو أرادهن لقال إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس
وثانيها
أن أهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم لأنه لما نزلت هذه الآية لف الرسول صلى الله عليه و سلم عليهم كساء وقال هو أهل بيتي
وثالثها
أن كلمة إنما للحصر فهي تدل على أنه تعالى ما أراد
أن يزيل الرجس عن احد ألا عن أهل البيت وهذا غير جائز لأنه تعالى أراد زوال الرجس عن الكل وإذا تعذر حمله على ظاهره وجب حمله على زوال بعض الرجس عنهم لأن ذكر السبب لإرادة المسبب جائز وزوال الرجس هو العصمة
فإذن هذه الآية تدل على عصمة أهل البيت وكل من قال ذلك زعم أن المراد به علي وفاطمة والحسن والحسين لا غير فلو حملناه على غيرهم كان ذلك قولا ثالثا
قلت الجواب عن الأول
أن التذكير لا يمنع من إرادتهن بالخطاب وإنما يمنع من القصر عليهن
وعن الثاني
أنه معارض بما يروى عن أم سلمة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ألست من أهل البيت فقال بلى إن شاء الله
ولأن لفظ أهل البيت حقيقة فيهن لغة فكان تخصيصه ببعض الناس خلاف الأصل
وعن الثالث
لا نسلم دلالة الآية على زوال كل رجس لأن المفرد المعرف لا يفيد العموم
والجواب عن التمسك بالخبر
أنه من باب الآحاد وعند الإمامية لا يجوز العمل به فضلا عن العلم
فإن قلت بل هو صيح ! قطعا لأن الأمة اتفقت على قبوله
بعضهم للاستدلال به على أن إجماع العترة حجة وبعضهم للاستدلال به على فضيلتهم
قلت قد تقدم أن هذا لا يفيد القطع بالصحة
سلمنا صحة الخبر لكنه يقتضي وجوب التمسك بالكتاب والعترة وذلك مسلم فلم قلتم إن قول العترة وحدها حجة
( و ) الجواب عن التمسك بالمعنى انه باطل بزوجاته صلى الله عليه و سلم فإنهن شاهدن اكثر احواله مع ان قولهن ليس وحده بحجة المسألة السادسة
إجماع الأئمة الأربعة وحدهم ليس بحجة
وحكى أبو بكر الرازي أن أبا حازم القاضي كان يقول إجماع الخلفاء الأربعة حجة ولهذا لم يعتد بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام وحكم برد أموال حصلت في بيت مال المعتضد إلى ذوي الأرحام وقبل المعتضد فتياه وأنفذ قضاءه وكتب به إلى الآفاق
ومن الناس من جعل إجماع الشيخين حجة
واحتج أبو حازم بقوله عليه الصلاة و السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد
واحتج الباقون بقوله عليه الصلاة و السلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ولما لم يكن الاقتداء بهما حال اختلافهما وجب ذلك حال اتفاقهما
والجواب
أنه معارض بقوله صلى الله عليه و سلم أصحابي كالنجوم بأيهم أقتديهم اهتديتم مع أن قول كل واحد من
الصحابة وحده ليس بحجة
المسألة السابعة
إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافا لبعضم
لنا
لو كان قول التابعي باطلا لما جاز رجوع الصحابة إليه لكنهم قد رجعوا إليه
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن فريضة فقال سلوها سعيد بن جبير فإنه أعلم به
وعن أنس رضي الله عنه ربما سئل عن شيء فقال سلوا
مولانا الحسن فإنه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا
وسئل ابن عباس عن النذر بذبح الولد فأشار إلى مسروق فأتاه السائل بجوابه فتابعه عليه وفي أمثال هذه الروايات كثرة
واحتج المخالف بالآية والخبر والأثر
أما الآية فقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ولن يرضى عنهم إلا إذا كانوا غير مقدمين
على فعل شيء من المحظورات ومتى كذلك كان قولهم حجة
أما الخبر فقوله عليه الصلاة و السلام لو أنفق غيرهم ملأ الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وذلك يدل على أن التابعي إذا خالف فالحق ليس مع التابعي بل معهم
وأما الأثر فهو أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على ابي سلمة بن عبد الرحمن خلافه على ابن عباس في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل وقالت فروج يصيح مع الديكة
و الجواب عن الأول
أن الآية مختصة بأهل بيعة الرضوان وبالاتفاق لا اختصاص لهم بالإجماع
وعن الخبر
أنه يلزم منه أن الصحابي الواحد إذا قال نقيض قول التابعي أن نقطع بأن الحق قول الصحابي
وعن الأثر
أن إنكارها على أبي سلمة لعله كان لأنه خالف بعد الإجماع أو في مسألة قطعية أو لأنه خالف قبل أن كان أهلا للاجتهاد
أو لأنه أساء الأدب في المناظرة
ولأن قول عائشة رضي الله عنهما ليس بحجة
المسألة الثامنة
اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفة المخطئين من أهل القبلة في مسائل الأصول
فإن لم نكفرهم اعتبرنا قولهم لأنهم اذا كانوا من المؤمنين ومن الأمة كان قول من عداهم قول بعض المؤمنين فلا يكون حجة
وإن كفرناهم انعقد الإجماع بدونهم لكن لا يجوز التمسك بإجماعنا عن كفرهم في تلك المسائل لأنه إنما ثبت خروجهم عن الإجماع بعد ثبوت كفرهم في تلك المسائل فلو أثبتنا كفرهم فيها بإجماعنا وحدنا لزم الدور
واعلم أن قول العصاه من أهل القبلة معتبر في الإجماع لأن من مذهبنا أن المعصية لا تزيل اسم الإيمان فيكون قول من عداهم قول بعض المؤمنين فلا يكون حجة
المسألة التاسعة
الإجماع لا يتم مع مخالفة الواحد والإثنين خلافا لأبي الحسين الخياط من المعتزلة ومحمد بن جرير الطبري وأبي بكر الرازي
لنا
أن جمع الصحابة أجمعوا على ترك قتال مانعي الزكاة وخالفهم فيه أبو بكر رضي الله عنه وحده فيه ولم يقل أحد إن خلافه غير معتد به بل لما ناظروه رجعوا إلى قوله
وكذلك ابن عباس وابن مسعود خالفا كل الصحابة في المسائل الفرائض وخلافهما باق إلى الآن
واحتج المخالف بأمور
أحدها
أن لفضي المؤمنين و الأمة يتناولهم مع خروج الواحد والإثنين منهم كما يقال في البقرة إنها سوداء وإن كانت فيها شعرات بيض وكما يقال للزنجي إنه أسود مع بياض حدقته وأسنانه
وثانيها
قوله عليه الصلاة و السلام عليكم بالسواد الأعظم وقوله الشيطان مع الواحد وهذا يقتضي أن الواحد المنفرد بقوله مخطيء
وثالثها أن الإجماع حجة على المخالف فلو لم يكن في العصر مخالف لم يتحقق هذا المعنى
ورابعها
أن الصحابة أنكرت على ابن عباس خلافة للباقين في الصرف
وخامسها
أن المسلمين اعتمدوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على الإجماع مع مخالفة سعد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه
وسادسها
أن في رواية الأخبار يحضل الترجيح بكثرة العدد فكذا في أقوال المجتهدين
وسابعها
أن تفاق الجمع على الكذب ممتنع عادة واتفاق الجمع القليل على ذلك غير ممتنع فإذا اتفقت الأمة على الحكم الواحد إلا الواحد منهم أو الإثنين كان ذلك الجمع العظيم قد أخبروا عن أنفسهم بكونهم مؤمنين وذلك لا يحتمل الكذب وأما الواحد والإثنان لما أخبروا عن أنفسهم بكونهم مؤمنين فذلك يحتمل الكذب
وإذا كان كذلك كان ما اتفق عليه الكل سوى الواحد والإثنين هو سبيل المؤمنين قطعا فوجب أن يكون حجة
وثامنها
لو اعتبرنا مخالفة الواحد والإثنين لم ينعقد الإجماع قطعا لأنه لا يمكننا أن ندعي في شيء من الإجماعات أنه ليس هناك واحد أو اثنان يخالفون فيه
و الجواب عن الأول
أن ألفاظ العموم لا تتناول الأكثر على سبيل الحقيقة في اللغة لأنه يجوز أن يقال لما عدا الواحد من الأمة ليسوا كل الأمة ويصح استثناوه عنهم
وعن الثاني
أن السواد الأعظم كل الأمة لأن من عدا الكل فالكل أعظم منه ولولا ما ذكرناه لدخل تحته النصف من الأمة إذا زاد على النصف الآخر بواحد
وأما قوله عليه الصلاة و السلام الشيطان مع الواحد فذلك لا يقتضي أن يكون مع كل واحد وإلا لم يكن قول الرسول صلى الله عليه و سلم وحده حجة
وعن الثالث
أنه حجة على المخالف الذي يوجد بعد ذلك ولو كان
الأمر كما ذكرتم لوجب في كل إجماع أن يكون فيه مخالف شاذ
وعن الرابع
أن الصحابة ما أنكروا على ابن عباس مخالفته للإجماع بل مخالفته خبر أبي سعيد رضي الله عنهما
وعن الخامس أن الإمامة لا يعتبر في انعقادها حصول الإجماع بل البيعة كافية
وعن السادس
لم قلتم إن الحال في الإجماع كالحال في الرواية فلو كان كذلك لحصل الإجماع بقول الواحد والإثنين كالرواية
وعن السابع
أنا وإن عرفنا في ذلك الجمع كونهم مؤمنين لكنا لا ندري أنهم كل المؤمنين فلا جرم لم يجب علينا أن نحكم بقولهم
وعن الثامن
أنا إنما نتمسك بالإجماع حيث يمكننا العلم
بذلك كما في زمان الصحابة رضي الله عنهم
المسألة العاشرة
الإجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنا من الاجتهاد وإن لم يكن مشهورا له لم يكن حجة لأن قول من عداه قول بعض المؤمنين فلا يندرج تحت أدلة الإجماع والله أعلم
القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
المسألة الأولىلا يجوز حصول الإجماع إلا عن دلالة أو أمارة
وقال قوم يجوز صدوره عن التبخيت
لنا
أن القول في الدين بغير دلالة أو أمارة خطأ فلو اتفقوا عليه لكانوا مجمعين على الخطأ وذلك يقدح في الإجماع
احتج المخالف بأمرين
الأول أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن دليل لكان ذلك الدليل هو
الحجة ولا يبقى في الإجماع فائدة
الثاني
أن الإجماع لا عن الدلالة و لا عن الأمارة قد وقع كإجماعهم على بيع المراضاة وأجرة الحمام
و الجواب عن الأول
أن ذلك يقتضي أن لا يصدر الإجماع عن دلالة ولا عن أمارة ألبتة وأنتم لا تقولون به
ولأن فائدة الإجماع أنه يكشف عن وجود دليل في المسألة من غير حاجة إلى معرفة ذلك الدليل والبحث عن كيفية دلالته على المدلول
وعن الثاني
أن الصور التي ذكرتموها غايتكم أن تقولوا لم ينقل إلينا فيها دليل ولا أمارة ولا يمكنكم القطع بأنهما ما كانا موجودين فلعلها كانا موجودين لكن تركوا نقلهما للاستغناء بالإجماع عنهما
المسألة الثانية
القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق اتفقوا على جواز وقوعه عن الدلالة
والحق عندنا جواز وقوعه عن الأمارة أيضا
وقال ابن جريرالطبري ذلك غير ممكن
ومنهم من سلم الإمكان ومنع الوقوع
ومنه من قال الأمارة إن كانت جلية جاز وإلا فلا
لنا
أن ذلك قد وقع روي عن عمر رضي الله عنه أنه شاور الصحابة في حد الشارب فقال علي رضي الله عنه إذا شرب سكر واذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون
وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا حد وأقل الحد ثمانون
فإن قلت لعلهم أجمعوا على تبليغ الحد ثمانين لنص استغنوا بالإجماع عن نقله
قلت هذا جائز لو لم ينصوا على فزعهم إلى الإجتهاد في هذه المسألة
وأيضا
أثبتوا إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالقياس على تقديم النبي صلى الله عليه و سلم إياه في الصلاة ثم أجمعوا عليها
واحتج المخالف بأمور
أحدها
أن الأمة على كثرتها واختلاف دواعيها لا يجوز أن تجمعها الأمارة مع خفائها كما لا يجوز اتفاقهم في الساعة الواحدة على أكل الزبيب الأسود والتكلم باللفظة الواحدة
وهذا بخلاف إجماعهم على مقتضى الدليل والشبهة لأن الدلالة قوية والشبهة تجري مجرى الدلالة عند من صار إليها
وبخلاف اجتماع الخلق العظيم في الأعياد لأن الداعي إليه ظاهر
وثانيها
من الأمة من يعتقد بطلان الحكم بالأمارة وذلك يصرفه عن الحكم بها
وثالثها
أن ذلك يفضي إلى اجتماع أحكام متنافية لأن الحكم الصادر عن الاجتهاد لا يفسق مخالفة وتجوز مخالفته ولا يقطع عليه ولا على تعلقه بالأمارة والحكم المجمع عليه بالعكس في هذه الأمور فلو صدر الإجماع عن الإجتهاد لاجتمع النقيضان فيه
والجواب عن الأول
أنه منقوض باتفاق أصحاب الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله على قوليهما
وعن الثاني
أن الخلاف في صحة القياس حادث
ولأنه يجوز أن تشتبه الأمارة بالدلالة فيثبت الحكم بالأمارة على اعتقاد أنه أثبته بالدلالة
ولأنه ينتقض بالعموم وخبر الواحد فإنه يجوز صدور الإجماع عنهما مع وقوع الخلاف فيهما
وعن الثالث
أن تلك الأحكام المرتبة على الاجتهاد مشروطة بأن لا تصير المسألة إجماعية فإذا صارت إجماعية فقد زال الشرط فتزول تلك الأحكام والله أعلم
المسألة الثالثة
قال أبو عبد الله البصري الإجماع الموافق لمقتضى خبر يدل على أن ذلك الإجماع لأجل ذلك الخبر
والحق أنه غير واجب لأن قيام الدلائل الكثيرة على المدلول
الواحد جائز فلعلهم أثبتوا مقتضى الخبر بدليل اخر سواه والله أعلم
القسم الخامس
في المجمعينقبل الخوض في المسائل لا بد من مقدمة وهي
أن الخطأ جائز عقلا على هذه الأمة كجوازه على سائر الأمم لكن الأدلة السمعية منعت منه
وهي واردة بلفظين
أحدها
لفظ المؤمنين في آية المشاقة
والآخر
لفظ الأمة في سائر الآيات والخبر
فأما لفظ المؤمنين فقد مر في باب العموم أنه للاستغراق
وأما لفظ الأمة فإنه يتناول كافة الأمة
فعلى هذا يجب أن يكون المعتبر قوق كل المؤمنين وقول كل الأمة فإن خرج البعض فلا بد من دليل منفصل
وإن اكتفينا بالبعض لم يمكن إثباته بهذه الأدلة بل لا بد من دليل اخر إلا أن هذه الأدلة كما لا تقتضي ذلك الحكم في البعض لا تمنع من ثبوته في البعض لأن ما يدل على ثبوت حكم في الكل لا يمنع من ثبوته في البعض ولا يلزم من انتفاء دليل معين انتفاء المدلول
المسألة الأولى
لا يعتبر في الإجماع اتفاق الأمة من وقت الرسول صلى الله عليه و سلم إلى يوم القيامة لأن الذي دل على الإجماع دل على وجوب الاستدلال به وذلك الاستدلال إما أن يكون قبل يوم القيامة وهو محال على التقدير الذي
قالوه لجواز أن يحدث بعد ذلك قوم آخرون
أو بعده وهو باطل لأنه لا حاجة في ذلك الوقت إلى الاستدلال
المسألة الثانية
لا عبرة في الإجماع بقول الخارجين عن الملة لأن آية المشاقة دالة على وجوب اتباع المؤمنين وسائر الأدلة دالة على وجوب اتباع الأمة والمفهوم من الأمة في عرف شرعنا الذين قبلوا دين الرسول صلى الله عليه و سلم
المسألة الثالثة
لا عبرة بقول العوام خلافا للقاضي أبي بكر رحمه الله
لنا وجوه
أحدها
أن العالم إذا قال قولا وخالفه العامي فلا شك أن قول العامي حكم في الدين بغير دلالة ولا أماره فيكون خطأ فلو كان قول العالم أيضا خطأ لكانت الأمة بأسرها مخطئة في مسألة واحد وإن كان ذلك الخطأ من وجهين ولكنه غير جائز
وثانيها
أن العصمة من الخطأ لا تتصور إلا في حق من تتصور في حقه الإصابة والعامي لا يتصور في حقه ذلك لأن القول في الدين بغير طريق غير صواب
وثالثها
أن خواص الصحابة رضي الله عنهم وعوامهم أجمعوا على أنه لا عبرة بقول العوام فى هذا الباب
ورابعها
أن العامي ليس من أهل الاجتهاد فلا عبرة بقوله كالصبي والمجنون
احتج المخالف
بأن أدلة الإجماع تقتضي متابعة الكل
والجواب
إيجاب متابعة الكل لا يقتضي أن لا يجب إلا متابعة الكل والأدلة التي ذكرناها تقتضي وجوب متابعة العلماء فوجب القول به
المسألة الرابعة
المعتبر بالإجماع في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك
الفن وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره
مثلا العبرة بالاجماع في مسائل الكلام بالمتكلمين وفي مسائل الفقه بالمتمكنين من الاجتهاد في مسائل الفقه فلا عبرة بالمتكلم في الفقه ولا بالفقيه في الكلام بل من يتمكن من الاجتهاد في الفرائض دون المناسك يعتبر وفاقه وخلافه في الفرائض دون المناسك
ولا عبرة أيضا بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن متمكنا من الاجتهاد
والدليل على هذه المسائل أن هؤلاء كالعوام فيما لا يتمكنون من الاجتهاد فيه فلا يكون بقولهم عبرة
أما الأصولي المتمكن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظا للأحكام فالحق أن خلافه معتبر خلافا لقوم
والدليل عليه أنه متمكن من الاجتهاد الذي هو الطريق إلى
التمييز بين الحق والباطل فوجب أن يكون قوله معتبرا قياسا على غيره
المسألة الخامسة
لا يعتبر في المجمعين بلوغهم إلى حد التواتر لأن الآيات والأخبار دالة على عصمة الأمة والمؤمنين فلو بلغوا والعياذ بالله إلى الشخص الواحد كان مندرجا تحت تلك الدلالة فكان قوله حجة
فأما من أثبت الإجماع بالعقل من حيث إن اتفاقهم يكشف عن وجود الدليل فيعتبر فيه بلوغ المجمعين حد التواتر لكنه باطل عندنا على ما مر
المسألة السادسة
إجماع غير الصحابة حجة خلافا لأهل الظاهر
لنا
أن التابعين إذا اجمعوا كان قولهم سبيلا للمؤمنين فيجب اتباعه بالآية
فإن قلت الآية إنما دلت على وجوب اتباع سبيل المؤمنين الذين كانوا حاضرين عند نزول الآية لأنهم كانوا هم المؤمنين أما الذين سيوجدون بعد ذلك فلا يصدق عليهم في ذلك الوقت أنهم مؤمنون
قلت فهذا يقتضي أنه لو مات من أؤلئك الحاضرين واحد أن لا ينعقد الإجماع بعد ذلك لكن كثيرا منهم مات قبل وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم وإن لم نقطع بذلك لكن لا يمكننا القطع ببقائهم بعد وفاته فيكون الشك فيه شكا في انعقاد الإجماع
احتج المخالف بأمور
أحدها
أن أدلة الإجماع لا تتناول إلا الصحابة فلا يجوز القطع بأن إجماع غيرهم حجة
بيان الأول أن قوله عز و جل وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس لا شك أنه خطاب مواجهة فلا يتناول إلا الحاضرين
وأما قوله عز و جل ويتبع غير سبيل المؤمنين فكذلك لأن من سيوجد بعد ذلك لا يصدق عليه في الحال اسم المؤمنين فالآية لا تتناول إلا من كان مؤمنا حال نزولها
وكذا القول في قوله صلى الله عليه و سلم أمتي لا تجتمع على خطأ
وإذا ثبت أن هذه الأدلة لا تتناول إلا الصحابة وثبت أنه لا طريق إلى إثبات الإجماع إلا هذه الأدلة وجب أن لا يكون إجماع غير الصحابة حجة
وثانيها
أن أهل العصر الثاني لو أجمعوا لكان إجماعهم إما أن يكون لقياس أو لنص
والأول باطل لأن القياس ليس بحجة عند الكل فلا يجوز أن يكون طريقا إلى صدور الإجماع من لكل فيبقى الثاني وهو أنهم إنما أجمعوا من جهة النص والنص إنما وصل إليهم من الصحابة فكان إجماع الصحابة على ذلك الحكم لأجل ذلك النص أولى فلما لم يوجد إجماعهم علمنا عدم ذلك النص
وثالثها
أنه لا بد في الإجماع من اتفاق الكل والعلم باتفاق الكل لا يحصل إلا عند مشاهدة الكل مع العلم بأنه ليس هناك أحد سواهم وذلك لا يتأتى إلا في الجمع المحصور كما في زمان الصحابة
أما في سائر الأزمنة فمع كثرة المسلمين وتفرقهم في
مشارق الأرض ومغاربها يستحيل أن يعرف أتفاقهم على شيء من الأشياء
ورابعها
أن الصحابة أجمعوا على أن كل مسألة لا تكون مجمعا عليها فأنه يجوز الاجتهاد فيها فالمسألة التي لا تكون مجمعا عليها بين الصحابة تكون محلا للاجتهاد بإجماع الصحابة فلو أجمع التابعون عليها لخرجت عن أن تكون محلا للإجتهاد وذلك يفضي إلى تناقض الإجماعين
وخامسها
أن الصحابة إذا اختلفت على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لا يصير القول الثاني مهجورا كما تقدمت هذه المسألة
وإذا كان كذلك فنقول المسألة التي أجمع التابعون عليها يحتمل أن يكون لواحد من الصحابة فيها قول يخالف قول التابعين مع أن ذلك القول لم ينقل إلينا ومع هذا الاحتمال لا يثبت الإجماع
فإن قلت لو فتحنا هذا الباب لزم أن لا يبقى شيء من النصوص دليلا على شيء من الأحكام لاحتمال طريان النسخ والتخصيص
قلت الفرق أن حصول إجماع التابعين مشروط بأن لا يكون
لأحد من الصحابة قول يخالف قولهم فالشك فيه شك في شرط يتوقف ثبوت الإجماع عليه فيكون ذلك شكا في حدوث الإجماع والأصل بقاؤه على العدم
وأما في مسألة الإلزام ف اللفظ بظاهره يقتضي العموم والشك إنما وقع في طريان المزيل والأصل عدم طريانه فظهر الفرق
و الجواب عن الأول
أن الذي ذكرتموه يقتضي أنه لما مات واحد من أولئك الحاضرين أن لا يبقى إجماع الباقين حجة وذلك يقضي إلى سقوط العمل بالإجماع وهم لا يقولون به
وعن الثاني
أنه يحتمل أن تكون تلك الواقعة ما وقعت في زمن الصحابة
فلم يتفحصوا عما يمكن الاستدلال به عليها ثم إنها وقعت في زمن التابعين فتفحصو عن الأدلة فوجودا بعض ما نقلته الصحابة دليلا عليه
وعن الثالث
أن حاصل ما ذكرتموه راجع إلى تعذر حصول الإجماع في غير زمان الصحابة وهذا لا نزاع فيه إنما النزاع في أنه لو حصل كان حجة
وعن الرابع
ما مر من الجواب عنه غير مرة
وعن الخامس
أنه يلزمكم أن لا يكون إجماع الصحابة حجة لاحتمال أن يكون الصحابي الذي مات قبل وفاة الرسول عليه الصلاة و السلام له فيه قول والله أعلم
القسم السادس
فيما عليه ينعقد الاجماع
المسألة الأولى
كل ما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به أمكن إثباته بالإجماع
وعلى هذا لا يمكن إثبات الصانع وكونه تعالى قادرا عالما بكل المعلومات وإثبات النبوه بالإجماع
أما حدوث العالم فيمكن إثباته به لأنه يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراض ثم نعرف صحة النبوة ثم نعرف به الإجماع ثم نعرف به حدوث الأجسام
وأيضا
يمكن التمسك به في أن الله عز و جل واحد لأننا قبل العلم بكونه واحدا يمكننا أن نعلم صحة الإجماع
المسألة الثانبة
اختلفوا في أن الإجماع في الآراء والحروب هل هو حجة منهم من أنكر ومنهم من قال إنه حجة بعد استقراء الرأي وأما قبله فلا والحق أنه حجة مطلقا لأن أدلة الإجماع غير مختصة ببعض الصور
المسألة الثالثة
هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين وأحد القسمين مخطئون في مسألة والقسم الآخر مخطئون في مسألة أخرى مثل إجماع شطر الأمة على أن القاتل لا يرث والعبد يرث وإجماع الشطر الآخر على أن القاتل يرث والعبد لا يرث
والأكثرون على أنه غير جائز لأن خطأهم في مسألتين لا يخرجهم عن أن يكونوا قد اتفقوا على الخطأ وهو منفي عنهم ومنهم من جوزه وقال لأن الخطأ ممتنع على كل الأمة لا على بعض الأمة والمخطئون في كل واحدة من المسألتين بعض الأمة
المسألة الرابعة
لا يجوز اتفاق الأمة على الكفر وحكى عن قوم أنه يجوز أن ترتد الأمة لأنها إذا فعلت ذلك لم يكونوا مؤمنين ولا سبيلهم سبيل المؤمنين وإذا كذبت الرسول خرجت من أن تكون من أمته
وجه القول الأول أن الله عز و جل أوجب اتباع سبيل المؤمنين واتباع سبيلهم مشروط بوجود سبيلهم وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب هذا إذا حملنا لفظ المؤمنين على الإيمان بالقلب أما إذا حملناه على التصديق باللسان ظهر أن الآية دالة على أن المصدقين في الظاهر لا يجوز إجماعهم على الخطأ ذلك يؤمننا من إجماعهم على الكفر
المسألة الخامسة
يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به لأن عدم
العلم بذلك الشيء إذا كان صوابا لم يلزم من إجماعهم عليه محذور
وللمخالف أن يقول لو اجمعوا على عدم العلم بذلك الشيء لكان عدم العلم به سبيلا للمؤمنين فكان يجب اتباعهم فيه حتى يحرم تحصيل العلم به
القسم السابع في حكم الاجماع
المسألة الأولىجاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر خلاف لبعض الفقهاء
لنا
أن أدلة أصل الإجماع ليست مفيدة للعلم فما تفرع عليها أولى أن لا يفيد العلم بل غايته الظن ومنكر المظنون لا يكفر بالإجماع
وأيضا
فبتقدير أن يكون أصل كون الإجماع حجة معلوما لا مظنونا لكن العلم به غير داخل في ماهية الاسلام وإلا لكان من الواجب على الرسول صلى الله عليه و سلم أن لا يحكم بإسلام أحد حتى يعرفه أن الإجماع حجة ولما لم يفعل ذلك بل لم يذكر هذه المسألة صريحا طول عمره صلى الله عليه و سلم علمنا أن العلم به ليس داخلا في ماهية الإسلام وإذا لم يكن العلم بأصل الإجماع معتبرا في الإسلام وجب أن لا يكون العلم بتفاريعه داخلا فيه
المسألة الثانية
الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة خلافا للحاكم صاحب المختصر
لنا
أنهم لما أجمعوا على ذلك الحكم صار سبيلا لهم فوجب اتباعه للآية
فإن قلت ومن سبيلهم إثباته بالاجتهاد وجواز القول بخلافه إذا لاح اجتهاد اخر
قلت ومن سبيلهم إثباته بطريق كيف كان فأما تعينه فقد أجمعوا على أنه غير معتبر
وعن الثاني
أن تجويزهم القول بخلافة حاصل لا مطلقا بل بشرط أن لا يحصل الأتفاق
المسألة الثالثة
اختلفوا في أنه هل يجوز انعقاد الإجماع بعد إجماع على خلافه
ذهب أبو عبد الله البصري إلى جوازه لأنه لا امتناع في إجماع الأمة على قول شرط أن لا يطرأ عليه إجماع اخر ولكن أهل الإجماع لما اتفقوا على أن كل ما أجمعوا عليه
فإنه واجب العمل به في كل الأعصار فلا جرم أمنا من وقوع هذا الجائز
وذهب الأكثرون إلى أنه غير جائز لأنه يكون أحدهما خطأ لا محالة وإجماعهم على الخطأ غير جائز
والقول الأول عندنا أولى
المسألة الرابعة
إذا أجمعوا على شيء وعارضه قول الرسول صلى الله عليه و سلم فإما أن يعلم أن قصد النبي صلى الله عليه و سلم بكلامه ما هو ظاهره وقصد أهل الإجماع بكلامهم ما هو ظاهره
أو يعلم احدهما دون الثاني
أو لا يعلم واحد منهما
والأول غير جائز لامتناع تناقض الأدلة
وإن كان الثاني قدمنا ما علم ظهوره
وإن كان الثالث فإن كان أحدهما أخص من الآخر خصصنا الأعم بالأخص توفيقا بين الدليلين بقدر الإمكان
وإن لم يكن كذلك تعارضا لأنا نقطع بأن النبي صلى الله عليه و سلم والأمة أراد أحدهما بكلامه غير ظاهرة لكنا لا نعلم أيهما كذلك فلا جرم يتساقطان والله أعلم
الكلام في الأخبار وهو مرتب على مقدمه وقسمين
أما المقدمة ففيها مسائل
المسألة الأولى
لفظ الخبر حقيقة في القول المخصوص وقد يستعمل في غير القول كقول الشاعر
تخبرني العينان ما القلب كاتم ...
وكقول المعري
نبي من الغربان ليس على شرع ... يخبرنا أن الشعوب إلى صدع ...
وكقولهم خبر الغراب بكذا لكنه مجاز فيه بدليل أن من وصف غيره بأنه مخبر أو أخبر لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول
المسألة الثانية
ذكروا في حده أمورا ثلاثة
أحدها
أنه الذي يدخله الصدق أو الكذب
وثانيها
أنه الذي يحتمل التصديق أو التكذيب
وثالثها
ما ذكره أبو الحسين البصري وهو أنه كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا
قال واحترزنا بقولنا بنفسه عن الأمر فإنه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لأن ماهية الأمر استدعاء الفعل والصيغة لا تفيد إلا هذا القدر
ثم إنها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك وكذا القول في دلالة النهي على قبح الفعل فأما قولنا هذا الفعل واجب أو قبيح فإنه يفيد بصريحه تعلق الوجوب أو القبح بالفعل
وأعلم أن هذه التعريفات ردية أما الأول فلان الصدق والكذب نوعان تحت الخبر والجنس
جزء من ماهية النوع وأعرف منها فإذن لا يمكن تعريف الصدق والكذب إلا بالخبر فلو عرفنا الخبر بهما لزم الدور
واعترضوا عليه أيضا من ثلاثة أوجه
أحدها
أن كلمة أو للترديد وهو ينافي التعريف ولا يمكن إسقاطها هاهنا لأن الخبر الواحد لا يكون صدقا وكذبا معا
وثانيها ان كلام الله عز و جل لا يدخله الكذب فكان خارجا عن هذا التعريف
وثالثها
أن من قال محمد ومسيلمة صادقان فإن هذا خبر مع أنه ليس بصدق ولا كذب
ويمكن أن يجاب عن الأول
بأن المعرف لماهية الخبر أمر واحد وهم إمكان تطرق أحد هذين الوصفين إليه وذلك لا ترديد فيه
وعن الثاني
أن المعتبر إمكان تطرق أحد هذين الوصفين إليه وخبر الله تعالى كذلك لأنه صدق
وعن الثالث ان قوله محمد ومسيلمة صادقان خبران وإن كانا في اللفظ خبرا واحدا لأنه يفيد إضافة الصدق إلى محمد عليه الصلاة و السلام و الى مسيلمة وأحد الخبرين صادق والثاني كاذب
سلمنا أنه خبر واحد لكنه كاذب لأنه يقتضي إضافة الصدق إليهما معا وليس الأمر كذلك فكان كذبا لا محالة
وأما التعريف الثاني فالاعتراض عليه
أن التصديق والتكذيب عبارة عن الإخبار عن كون الخبر صدقا وكذا فقولنا الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب جار مجرى أن يقال الخبر هو الذي يجوز الإخبار عنه بأنه صدق أو كذب فيكون هذا تعريفا للخبر بالخبر وبالصدق والكذب
والأول هو تعريف الشيء بنفسه
والثاني تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به
وأما الثالث فالاعتراض عليه من ثلاثة أوجه
أحدها
أن وجود الشيء عند أبي الحسين عين ذاته فإذا قلنا إن السواد موجود فهو خبر مع أنه إضافة شيء إلى شيء اخر
فإن قلت السؤال إنما يلزم أن لو قال إضافة أمر إلى أمر اخر وإنه لم يقل ذلك بل قال إضافة أمر إلى أمر وهذا أعم من قولنا إضافة أمر إلى أمر اخر وايضا فقولنا السواد موجود معناه أن المسمى بلفظ السواد مسمى بلفظ الموجود
قلت الجواب عن الأول
أن الإضافة مشعرة بالتغاير إذ لو لم يكن ذلك معتبرا لدخل اللفظ المفرد في الحد
وعن الثاني
أن موضع الإلزام ليس هو الإخبار عن التسمية بل عن وجوده وحصوله في نفسه ومعلوم أن من تصور ماهية المثلث أمكنه أن يشك في أنه هل هو موجود أم لا فموضع الإلزام ها هنا لا هناك
وثانيها
أنا إذا قلنا الحيوان الناطق يمشي فقولنا الحيوان الناطق يقتضي نسبة الناطق إلى الحيوان مع أنه ليس بخبر لأن الفرق بين النعت والخبر معلوم بالضرورة فإن قلت أزيد في الحد قيدا اخر فاقول إنه الذي يقتضي نسبة أمر إلى أمر بحيث يتم معنى الكلام والنعت ليس كذلك قلت إن عنيتم بكون الكلام تاما إفادته لمفهومه فذاك حاصل في النعت مع المنعوت لأن قول القائل الحيوان الناظق يفيد معناه بتمامه وإن عنيتم به إفادته لتمام الخبر لم يعقل ذلك إلا بعد تعقل الخبر فإذا عرفتم به الخبر لزم الدور وإن عنيتم به معنى ثالثا فاذكروه
وثالثها
أن قولنا نفيا وإثباتا يقتضي الدور لأن النفي هو الإخبار عن عدم الشيء والإثبات هو الإخبار عن وجوده فتعريف الخبر بهما دور
وإذا بطلت هذه التعريفات فالحق عندنا أن تصور ماهية الخبر غني عن الحد والرسم لدليلين
الأول
أن كل أحد يعلم بالضرورة معنى قولنا إنه موجود وإنه ليس بمعدوم وأن الشيء الواحد لا يكون موجودا و معدوما ومطلق الخبر جزء من الخبر الخاص والعلم بالكل موقوف على العلم بالجزء فلو كان تصور مطلق ماهية الخبر موقوفا على الاكتساب لكان تصور الخبر الخاص أولى أن يكون كذلك فكان يجب أن لا يكون فهم هذه الأخبار ضروريا ولما لم يكن كذلك علمنا صحة ما ذكرناه
والثاني
أن كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر ويميزه عن الموضع الذي يحسن فيه الأمر ولولا أن هذه الحقائق متصورة تصورا بديهيا وإلا لم يكن الأمر كذلك
فإن قلت الخبر نوع من أنواع الألفاظ والألفاظ ليست تصوراتها بديهية فكيف قلت إن ماهية الخبر متصورة تصورا بديهيا
قلت حكم الذهن بين أمرين بأن أحدهما له الآخر أو ليس له الآخر معقول واحد لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وكل أحد يدركه من نفسه ويجد التفرقة بينه وبين سائر أحواله النفسانية من ألمه ولذته وجوعه وعطشه
وإذا ثبت هذا فنقول إن كان المراد من الخبر هو الحكم الذهني فلا شك أن تصوره في الجملة بديهي مركوز في فطرة العقل
وإن كان المراد منه اللفظة الدالة على هذه الماهية فالاشكال غير
وارد أيضا لأن مطلق اللفظ الدال على المعنى البديهي التصور يكون أيضا بديهي التصور
المسألة الثالثة
قيل لا بد في الخبر من الإرادة لأن هذه الصيغة قد تجي ولا تكون خبرا إما لصدورها عن الساهي والحاكي أو لأن المراد منها الأمر مجازا كما في قوله تعالى والجروح قصاص وإذا كانت الصيغة صالحة للدلالة على الخبرية وعلى غيرها لم ينصرف الى أحد الأمرين دون الآخر إلا لمرجح وهو الإرادة أو الداعي
والكلام في هذا الأصل قد تقدم في أول باب الأمر
وأيضا
فلا معنى لكون الصيغة خبرا إلا أن المتلفظ تلفظ بها وكان مقصودة تعريف الغير ثبوت المخبر به للمخبر عنه أو سلبه عنه
وزعم أبو علي وأبو هاشم أن الصيغة حال كونها خبرا صفة معللة بتلك الإرادة وإبطاله أيضا قد مضى في أول باب الأمر
المسألة الرابعة
إذا قال القائل العالم حادث فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالم لا نفس ثبوت الحدوث للعالم إذ لو كان مدلوله نفس ثبوت الحدوث للعالم لكان حيثما وجد قولنا العالم محدث كان العالم محدثا لا محالة فوجب أن لا يكون الكذب خبرا
ولما بطل ذلك علمنا أن مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة لا نفس النسبة
بقي ها هنا البحث عن ماهية الحكم فإنه لا يجوز أن يكون المراد منه الاعتقاد لأن الإنسان قد يخبر عما لا يعتقد فيه ألبته لأن من لا يعتقد أن زيدا في الدار يمكنه والحالة هذه أن يقول زيد في الدار ولا يجوز أن يكون المراد منه الإرادة لأن الإخبار قد يكون عن الواجب والممتنع مع أن الإرادة يمتنع تعلقها به فلم يبق إلاأن يكون الحكم الذهني أمرا مغايرا لجنس الاعتقادات والقصود وذلك هو كلام النفس الذي لا يقول به أحد إلا أصحابنا
المسألة الخامسة
اتفق الأكثرون على أن الخبر لا بد وأن يكون إما صدقا وإما كذبا خلافا للجاحظ
والحق أن المسألة لفظية لأنا نعلم بالبديهة أن كل خبر فإما أن يكون مطابقا للمخبر عنه أو لا يكون
فإن أريد بالصدق الخبر المطابق كيف كان وبالكذب الخبر الغير المطابق كيف كان وجب القطع بأنه لا واسطة بين الصدق والكذب
وإن أريد بالصدق ما يكون مطابقا مع أن المخبر يكون عالما بأنه غير مطابق كان هناك قسم ثالث بالضرورة وهو الخبر الذي لا يعلم قائله أنه مطابق أم لا
فثبت أن المسألة لفظية فنقول
للجاحظ أن يحتج على قوله بالنص والمعقول
أما النص فقوله تعالى حكاية عن الكفار أفترى على الله كذبا أم به جنة جعلوا إخباره عن نبوة نفسه إما كذبا وإما جنونا مع أنهم كانوا يعتقدون أنه ليس برسول الله على التقديرين وهذا يقتضي أن يكون إخباره عن نبوة نفسه حال جنونه مع أنه ليس نبي عندهم لا يكون كذبا لأن المجعول في مقابلة الكذب لا يكون كذبا
وأما المعقول فمن وجهين
الأول
أن من غلب على ظنه أن زيدا في الدار فأخبر عن كونه في الدار ثم ظهر أنه ما كان كذلك لم يقل أحد إنه كذب في هذا الخبر
الثاني
أن أكثر العمومات والمطلقات مخصصة ومقيدة فلو كان الخبر الذي لا يطابق المخبر كذبا لتطرق الكذب إلى كلام الشارع
واحتج الجمهور
باتفاق الأمة على تكذيب اليهود والنصارى في كفرياتهم مع أنا نعلم أن فيهم من لا يعلم فساد تلك المذاهب ويمكن أن يجاب عنه
بأن أدلة الإسلام لما كانت جلية قوية كان حالهم شبيها بحال من أخبر عن الشيء مع العلم بفساده
تنبيه
واعلم أن الخبر إما أن يقطع بكونه صدقا أو بكونه كذبا أو لا يقطع بواحد منهما فلا جرم رتبنا هذا الكتاب على قسمين
القسم الأول في الخبر المقطوع به وهو إما أن يكون صدقا أو كذبا
أما الصدق فطريق هذا القطع إما أن يكون هو التواتر أو غيره
ونحن نتكلم أولا في التواتر ثم في سائر الطرق المفيدة للقطع ثم في الطرق التي يظن أنها تفيد القطع وإن لم تكن كذلك
الباب الأول في التواتر
المسألة الأولىالتواتر في أصل اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما مأخوذ من قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترا أي رسولا بعد رسول بفترة بينهما فكذا التواتر في المخبرين المراد به مجيئهم على غير الاتصال
وأما في اصطلاح العلماء فهو خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم
المسألة الثانية
أكثر العلماء
اتفقوا على أن أمثال هذه الأخبار قد تفيد العلم سواء أكان إخبارا على أمور موجودة في زماننا كالإخبار عن البلدان الغايبة أو عن أمور ماضية كالإخبار عن وجود الأنبياء والملوك الذي كانوا في القرون الماضية
وحكي عن السمنية أن خبر التواتر عن الأمور الموجودة في زماننا لا يفيد العلم اليقيني ألبتة بل الحاصل منه الظن الغالب القوي
ومنهم من سلم أن خبر التواتر عن الأمور الموجودة في زماننا يفيد العلم لكن الخبر عن الأمور الماضية في القرون
الحالية لا يفيد العلم ألبتة
لنا
أنا نجد أنفسنا جازمة ساكنة بوجود البلاد الغائبة والأشخاص الماضية جزما خاليا عن التردد جاريا مجرى جزمنا بوجود المشاهدات فيكون المنكر لها كالمنكر للمشاهدات فلا يستحق المكالمة
قال الخصم أنا لا أنكر وجود الظن الغالب القوي الذي لا يكاد يتميز عند الأكثرين عن اليقين التام لكن الكلام في أنه هل حصل اليقين أو لا
والذي يدل على أن الحاصل ليس بيقين وجهان
الأول
أنا إذا عرضنا على عقولنا أن الواحد نصف الإثنين وعرضنا على عقولنا وجود جالينوس وفلان وفلان عند هذه الأخبار
المتواترة وجدنا الجزم الأول أقوى وآكد من الجزم الثاني وقيام التفاوت يدل على احتمال تطرق النقيض إلى الاعتقاد الثاني وقيام هذا الاحتمال فيه كيف كان يخرجه عن كونه يقينا
الثاني
أن جزمي بوجود هذه المخبرات ليس أقوى من جزمي بأن ولدي الذي أراه في هذه الساعة هو الذي رأيته بالأمس ثم هذا الجزم ليس بيقين لأنه يجوز أن يوجد شخص مساو لولدي في الشخص والصورة من كل الوجوه إما لأن القادر المختار خلقه أو لأن شيئا من التشكلات الفلكية يقتضي وجوده عند منكري القادر فثبت أن هذا الجزم ليس بيقين بل ظن فكذلك الجزم الحاصل عقيب خبر التواتر
فإذا قلت لو جوزنا أن يكون هذا الشخص الذي أراه الآن غير الذي رأيته بالأمس أدى ذلك إلى الشك في المشاهدات
قوله لعل القادر خلق مثله أو الشكل الغريب الفلكي اقتضاه
قلنا بل ها هنا قام برهان مانع منه وهو أن الله تعالى لو فعل ذلك لأفضى إلى اشتباه الشخص وذلك تلبيس وهو على الله تعالى محال
قلنا لا نسلم أن تجويزه يفضي إلى الشك في المشاهدات لأن المشاهد هو وجود هذا الذي أراه الآن فأما أن هذا هو الذي رأيته بالأمس فهو غير مشاهد فلا يلزم من تطرق الشك إلى هذا المعنى تطرقه إلى المشاهدات
وأما البرهان الذي ذكره على امتناع هذا الاحتمال فلا يدفع الإلزام لأن هذا الجزم لو كان بناء على ذلك البرهان لكان الجاهل بذلك البرهان خاليا عن ذلك الجزم لكن العوام لا يعرفون هذا البرهان فيجب أن لا يحصل لهم ذلك الجزم
والجواب
أن هذا تشكيك في الضروريات فلا يستحق الجواب كما أن شبه منكري المشاهدات لا تستحق الجواب لمثل هذا السبب
المسألة الثالثة
العلم الحاصل عقيب خبر التواتر ضروري وهو قول الجمهور خلافا لأبي الحسين البصري والكعبي من المعتزلة ولإمام
الحرمين والغزالي منا
وأما الشريف المرتضى من الشيعة فإنه كان متوقفا فيه
لنا
لو كان ذلك العلم نظريا لما حصل لمن لا يكون من أهل النظر كالصبيان والبله ولما حصل ذلك لهم علمنا أنه ليس بنظري
اعترض أبو الحسين والمرتضى على هذا الوجه بكلام واحد وهو أن النظر في ذلك ليس إلا ترتيب العلوم بأحوال المخبرين وهذا القدر حاصل للعامة والمراهقين لأنه قد حصل في عقولهم علوم كثيرة وهم يستنتجون من تركيبها علوما أخر
سلمنا أن ما ذكرته يدل على قولك لكن معنا ما يبطله من ثلاثة أوجه
الأول
ما ذكره أبو الحسين البصري وهو أن الاستدلال عبارة عن ترتيب علوم أو ظنون يتوصل بها إلى علوم أو ظنون وكل اعتقاد توقف وجوده على ترتيب اعتقادات أخر فهو استدلالي
والعلم الواقع بالتواتر هذا سبيله لأنا لا نعلم وجود ما أخبرنا أهل التواتر عنه إلا إذا علمنا أنه لا داعي للمخبرين إلى الكذب ولا لبس في المخبر عنه وأنه متى كان كذلك استحال كون الخبر كذبا وإذا بطل كونه كذبا ثبت كونه صدقا فالسامع لخبر التواتر ما لم يتقرر عنده كل واحدة من هذه المقدمات لم يحصل له العلم فكان ذلك العلم استدلاليا
الثاني
أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر لو كان ضروريا لكنا
مضطرين إليه بحيث لا يمكننا الانفكاك عنه ولو كان كذلك لعلمنا بالضرورة كوننا عالمين على سبيل الاضطرار بذلك وكان ينبغي أن يعلم بالضرورة كل عاقل كون هذا العلم ضروريا كما في سائر العلوم الضرورية ولما لم يكن كذلك علمنا أن هذا العلم ليس بضروري
الثالث
ذكره الكعبي وهو أنه لو جاز أن يعلم ما غاب عن الحس بالضرورة لجاز أن يعلم المحسوس بالاستدلال ولما بطل هذا بطل الأول
والجواب
قوله ذلك الاستدلال سهل يتأتى من كل أحد
قلنا سنبين إن شاء الله تعالى في فصل مفرد أن ذلك الاستدلال غامض جدا
وهو الجواب بعينه عن المعارضة الأولى
وعن الثاني
أن كون العلم ضروريا كيقية للعلم ويجوز أن يكون أصل الشيء معلوما وتكون كيفيته مجهولة
وعن الثالث
أنه لا بد من الجامع
المسألة الرابعة
استدل أبو الحسين البصري على أن خبر أهل التواتر صدق وقال لو كان كذبا لكان المخبرون إما أن يكونوا ذكروه مع علمهم بكونه كذبا أو لا مع علمهم بكونه كذبا والقسمان باطلان فبطل كونه كذبا فتعين كونه صدقا فكان مفيدا للعلم
إنما قلنا إنه لا يجوز أن يذكره المخبرون مع علمهم بكونه كذبا لأنهم على هذا التقدير إما أن يكونوا قصدوا فعل الكذب لغرض ومرجح أو لا لغرض ومرجح
والثاني محال
أما أولا فلان الفعل لا يحصل في وقت دون وقت إلا لمرجح وإلا لزم ترجح أحد الطرفين على الآخر من غير مرجح وهو محال
وأما ثانيا فلان كونه كذبا جهة قبح وجهة القبح صارفة عن الفعل ومع حصول الصارف القوي عن الفعل يستحيل حصول الفعل إلا لداع أقوى من ذلك الصارف
وأما القسم الأول
وهو أنهم قصدوا فعل الكذب لغرض فذلك الغرض إما نفس كونه كذبا أو شيء أخر
والأول باطل لأن كونه كذبا جهة صرف لا جهة دعاء
والثاني باطل لأن ذلك الغرض إما أن يكون دينيا أو دنيويا
وعلى التقديرين فإما أن يكون رغبة أو رهبة
وعلى التقديرات فإما أن يقال كلهم كذبوا لداع واحد من هذه الأقسام أو يقال فعله بعضهم لبعض هذه الدواعي وبعضهم للبعض الآخر
وعلى كل التقديرات فإما أن تحصل تلك الدواعي بالتراسل أو لا بالتراسل والأقسام كلها باطلة
أما أنه لا يجوز أن يكون للدين فلان قبح الكذب متفق عليه سواء كان ذلك بالعقل أو بالشرع فكان ذلك صارفا دينيا لا داعيا دينيا
وأما الرغبة الدنيوية فقد تكون رجاء عوض على الكذب أو لأجل أن يسمع غيره شيئا غريبا وإن كان لا أصل له
والأول باطل لأن كثيرا من الناس لا يرضى بالعوض الكثير في مقابلة الكذب وإن احتاج إليه وكذا القول في القسم الثاني
وأما الرهبة فهي لا تكون إلا من السلطان لكن السلطان لا يقدر على أن يجمع الجمع العظيم على الكذب ألا ترى أن السلطان لا يمكنه ذلك في جميع أهل بغداد لأنه لا يعلم كل واحد منهم حتى يجعله مضطرا إلى ذلك الكذب
ولأن السلطان كثيرا ما يخوف الناس عن التحدث بكلام مع أنهم آخر الأمر يقولونه حتى يصير مشهورا بينهم
ولأنا نعلم في كثير من الأمور أنه لا غرض للسلطان في أن يخبر عنه بالكذب
ولا يجوز أيضا أن يقال الجماعة العظيمة كذبوا بعضهم للرغبة وبعضهم للرهبة وبعضهم للتدين لأن كلامنا في جماعة عظيمة أبعاضها جماعات عظيمة يمتنع تساوي أجزائها في قوة هذه الدواعي
وأما القسم الثاني وهو أنهم كذبوا مع أنهم لم يعلموا كونهم كاذبين فذاك لا يمكن إلا إذا اشتبه عليهم الشيء بغيره والاشتباه في الضروريات باطل وشرط خبر التواتر أن يكون واقعا عما علم وجوده بالضرورة و هذا إذا أخبر المخبرون عن المشاهدة
و أما ما توسط بين من أخبرنا وبين من شاهد ذلك واسطة واحدة أو وسائط فإنه لا يحصل العلم بخبرهم إلا إذا علمنا كون الوسائط متصفين بالصفات المعتبرة في أهل التواتر وذلك إنما يعلم بطريقين
الأول
أن يكون أهل التواتر الذين رأيناهم أخبروا أن أولئك الذين مضوا كانوا مستجمعين للشرائط المعتبرة في أهل التواتر
والثاني
أن كل ما ظهر بعد خفاء وقوى بعد ضعف فلا بد وأن يشتهر فيما بين الناس حدوثه ووقت حدثوه فإن مقالة الجهمية
والكرامية لما حدثت بعد أن لم تكن لا جرم اشتهر في ما بين الناس وقت حدوثها فلما لم يظهر شيء من ذلك علمنا أن الأمر كان كذلك في كل الأزمنة
هذا تمام الاستدلال
والاعتراض عليه أن يقال لأبي الحسين
إما أن يكون غرضك من هذا الاستدلال ظنا قويا بكون الخبر صدقا فذلك مسلم
أو اليقين فلا نسلم أن ما ذكرته يفيد اليقين لأن التقسيم المفضي إلى اليقين يجب أن يكون دائرا بين النفي والإثبات ثم نبين فساد كل قسم سوى المطلوب بدليل قاطع وهذا الذي ذكره أبو الحسين ليس كذلك
فلنبين هذه الأشياء فنقول لم لا يجوز أن يقال كذبوا لا لغرض
قوله الفعل بدون المرجح محال
قلنا هذا لا يتم على مذهبك لأنه يقتضي الجبر وأنت لا تقول به بيان أنه يقتضى الجبر أن قادرية العبد صالحة للفعل والترك وإلا لزم الجبر فلو لم يترجح أحد الطرفين إلا لمرجح فذاك المرجح إن كان من فعل العبد عاد الطلب من أنه لم فعل مرجح أحد الطرفين دون الآخر
وإن كان ذلك لمرجح اخر من فعله لزم التسلسل أو ينتهي إلى مرجح ليس من فعله فعند حصول ذلك المرجح الذي ليس من فعله إما أن يكون ترتب أثره عليه واجبا أو لا يكون
واجبا فإن كان الأول لزم الجبر
وإن كان الثاني فهو باطل وبتقدير صحته فالإلزام عليك وارد
أما أنه باطل فلانه إذا لم يجب ترتب أثره عليه جاز حينئذ أن لا يترتب عليه في بعض الأوقات ذلك الأثر وجاز في وقت آخر أن يترتب إذ لو لم يجز ذلك أصلا لما كان ذلك مرجحا تاما وكلامنا في المرجح التام
وإذا كان كذلك فترتب الأثر عليه في أحد الوقتين دون الوقت الآخر إما أن يكون لمزية يختص بها ذلك الوقت دون الوقت الثاني وإما لا يكون كذلك
فإن كان الأول فقبل حصولك تلك المزية ما كان المرجح التام حاصلا لكنا قد فرضناه حاصلا هذا خلف
ثم إننا ننقل الكلام إلى تلك المزية فنبين أنها من فعل الله عز و جل وبعد حصولها فإن وجب ترتب الأثر عليها لزم الجبر
وإن لم يجب افتقر إلى مزية أخرى لا إلي نهاية وهو محال
وأما إن لم يكن ترتب الأثر على ذلك المرجح في ذلك الوقت لأجل حصول مزية في ذلك الوقت دون سائر الأوقات كانت نسبة تلك المزية إلى زماني ترتب الأثر عليه ولا ترتبه عليه على السواء ولا مرجح ولا مخصص ألبته فيكون اختصاص ذلك الوقت بترتب ذلك الأثر على ذلك المرجح دون الوقت الثاني يكون ترجيحا لأحد طرفي الممكن المساوي على الآخر من غير مرجح وهو محال
وقد بان بهذا أنه ما لم يحصل للعبد مرجح من قبل الغير يمتنع أن يكون فاعلا وإذا حصل المرجح وجب أن يكون فاعلا وهذا هو الجبر
وأما بتقدير أن لا يجب ذلك فالإشكال وارد لأن عند حصول مرجح الوجود إذا جاز أن لا يوجد الوجود كان اللاوجود واقعا لا عن مرجح أصلا وإذا جوزت ذلك
بطل قولك الفعل لا يقع إلا عن الداعي فلم لا يجوز في أهل التواتر أن يكذبوا لا لداع
وأما قوله ثانيا كونه كذبا جهة صرف لا جهة دعاء
قلنا هذا بناءا على أن الكذب قبيح لكونه كذبا وقد مر الكلام في إبطاله في أول الكتاب
سلمناه لكن عند حصول الصارف لو وجب الترك لزم الجبر وأنت لا تقول به
وإن لم يجب فقد جوزت عند حصول الصارف أن لا يقع العدم وجواز أن لا يقع العدم يقتضي جواز أن يقع الوجود فقد جوزت مع الصارف عن الفعل أن يوجد الفعل فلم يلزم من كون الكذب جهة صرف امتناع أن يوجد الكذب
سلمنا أنه لا بد من داع فلم لا يجوز أن يوجد فيه شهوة متعلقة بالكذب لكونه كذبا ومتى كان كذلك أقدم العاقل
على الكذب لا لغرض اخر سوى كونه كذبا
فإن قلت إنه من المحال أن يشتهي العاقل الكذب لمجرد كونه كذبا
وإن سلمنا جوازه لكن في حق الواحد والإثنين
أما في حق الجمع العظيم فمحال وهذا كما أنه جاز على كل واحد منهم وحده أن يأكل في الساعة المعينة من اليوم المعين طعاما واحدا لكن لا يجوز اتفاق الكل عليه
قلت
الجواب عن الأول
أنا لا نسلم امتناع ذلك فما الدليل عليه و كيف ونرى جمعا اعتادوا الكذب بحيث لا يصبرون عنه وإن كانوا يعلمون أن ذلك يضرهم عاجلا أو اجلا وإذا كان كذلك
علمنا أن دعوى الضرورة باطلة
وعن الثاني
نسلم أن استقراء العادة يفيد ظنا قويا بأن الخلق العظيم لا يتفقون على أكل طعام معين في زمان معين لكن لا نسلم حصول اليقين التام بذلك كيف وذلك جائز على كل واحد منهم وصدوره من كل واحد منهم لا يمنع صدوره عن الباقي فيكون صدوره عن كلهم كصدوره عن كل واحد منهم ومع هذه الحجة اليقينية على الجوار كيف تدعى ضرورة الامتناع
سلمنا أنه لا بد من غرض سوى كونه كذبا فلم قلت إن ذلك الغرض إما أن يكون دينيا أو دنيويا أو رغبة او رهبه وما الدليل القاطع على الحصر
سلمناه فلم لا يجوز أن يكون دينيا
قوله حرمة الكذب متفق عليها
قلنا مطلقا لا نسلم فإن كثيرا من الناس يعتقد أن الكذب
المفضى إلى حصول مصلحة في الدين جائز ولذلك نرى جمعا من الزهاد وضعوا أشياء كثيرة من الأحاديث في فضائل الأوقات وزعموا أن غرضهم منه حمل الناس على العبادات وإذا كان كذلك فلعلهم اتفقوا على الكذب لما أنهم اعتقدوا فيه حصول مصلحة دينية وإن كان الأمر بخلاف ما تخيلوه
سلمنا أنه ليس الغرض دينيا فلم لا يجوز أن يكون لرغبة دنيوية
قوله الرغبة إما أخذ المال أو إسماع الغير كلاما غريبا
قلنا أين الدليل على الحصر ثم اين الدليل القاطع على فساد هذين القسمين
قوله الجماعات العظيمة لا يشتركون في الرغبة إلى الكذب لأجل هذين الغرضين
قلنا إن أدعيت الظن القوي فلا نزاع وإن ادعيت الجزم المانع من النقيض فما الدليل عليه فإنه إذا جاز ذلك في العشرة
أو المائة ولم يكن ثبوت هذا الحكم للبعض مانعا من ثبوته للباقي فلم قلت إنه يمتنع كون الكل كذلك
والذي يؤكده أنا لو قدرنا أن أهل بلدة علموا أن أهل سائر البلاد لو عرفوا ما في بلدهم من الوباء العام لتركوا الذهاب إلى بلدهم ولو تركوا ذلك لاختلت المعيشة في تلك البلدة وقدرنا أن أهل تلك البلدة كانوا علماء حكماء جاز في مثل هذه الصورة أن يتطابقوا على الكذب وإن كانوا كثيرين جدا
فثبت بهذا إمكان اتفاق الخلق العظيم على الكذب لأجل الرغبة
سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يكون للرهبة
قوله السلطان لا يمكنه إسكات الكل
قلنا إن ادعيت الظن القوي فمسلم وإن ادعيت اليقين فما الدليل عليه فإنه إذا جاز إسكات الألف والألفين رهبة فلم لا يجوز إسكات الكل وما الضابط فيما يجوز وفيما لا يجوز
فإن قلت أجد العلم ضروري بذلك من غير دلالة
قلنا هذا الاعتقاد ليس أقوى من الاعتقاد الحاصل بوجود محمد وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فلم لا تدعون الضرورة في ذلك حتى تتخلصوا عن مثل هذه الدلالات الضعيفة
سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يقال إنهم كذبوا لدواع مختلفة بعضهم للرغبة وبعضهم للرهبة وبعضهم بالمراسلة وبعضهم بالمشافهة
قوله الكلام في جماعة عظيمة بعضها جماعات عظيمة
قلنا إما أن يكون من شرط أهل التواتر أن يكون أبعاضهم بالغين حد التواتر أو ليس من شرطهم ذلك
والأول باطل وإلا لزم أن يكون كل واحد من أبعاض تلك الأبعاض كذلك ولزم التسلسل
والثاني حق ونحن نفرض الكلام فيما إذا كان الأمر كذلك وحينئذ يبطل ما ذكروه
سلمنا أنهم ما كذبوا عمدا فلم لا يجوز أن يقال كذبوا
سهوا لأن الأمر اشتبه عليهم والاشتباه حاصل في المحسوسات بدليل العقل والنقل
أما العقل فمن وجهين
الأول أن الله تعالى قادر على أن يخلق شخصا اخر مثل زيد في شكله وفي تخطيطه وبهذا التقدير لا يبقى اعتمادا على التواتر لجواز أن يكونوا قد رأوا امثل زيد فظنوه زيدا
ومما يؤكد ذلك أن الأجسام المعدنية والنباتية قد تتشابه بحيث يعسر تمييز بعضها عن بعض وكذلك الحيوانا لا سيما البرية والجبلية قد تبلغ مشابهة بعضها بعض إلى حد يعسر التمييز
وإذا كان كذلك فلم لا يجوز مثله في الناس غايته أنه نادر و لكن الندرة لا تمنع الاحتمال
فإن قلت أن حكمته تعالى تمنعه من خلق شخص مثل زيد لما فيه من التلبيس
قلت قد سبق جوابه
الثاني أن غلط الناظر أمر مشهور فإن الإنسان قد يرى المتحرك ساكنا وبالعكس وذلك يقتضي حصول اللبس في الحسيات
وأما النقل فمن وجهين
الأول أن المسيح عليه السلام شبه بغيره
فإن قلت هذا لا يلزم من وجوه أحدها
أن ذلك كان في زمان عيسى عليه السلام وخرق العادة جائز في زمان الأنبياء دون سائر الأزمنة
وثانيها
أن المصلوب تتغير خلقته وشكله فيكون الاشتباه أكثر وأما المباشرون لذلك العمل فكانوا قليلين فيجوز عليهم الكذب عمدا
وثالثها
أنهم نظروا إليه من بعيد وذلك مظنة الاشتباه
قلت الجواب عن الأول
أنه لو جاز ذلك في زمان الأنبياء لجاز مثله في سائر أزمنة الأنبياء
وحينذ لا يمكننا القطع بأن الذي أوجب الصلوات الخمس هو المصطفى صلى الله عليه و سلم لجواز أن يكون شخصا اخر شبه به
وأيضا
فلم لا يجوز انخراق العادات في هذا الزمان ككرامات
الأولياء فان منعوها قلنا هذا لا يستقيم على قول أبي الحسين فإنه لا يمنعها
ولأن بتقدير امتناعها فليس ذلك الامتناع معلوما إلا بالبرهان فقبل العلم بذلك البرهان يكون التجويز قائما والعلم بصحة خبر التواتر موقوف على فساد هذا الاحتمال فوجب أن لا يحصل العلم بخبر التواتر لم لمن يعرف بالدليل امتناع الكرامات
وعن الثاني
أن التغير إنما يكون بعد الصلب والموت فأما حال الصلب فلا وعندكم أن الاشتباه حصل حال الصلب لأنهم لو ميزوا بين ذلك الشخص وبين المسيح عليه السلام لما صلبوا ذلك الشخص
وعن الثالث
أن الذين مارسوا الصلب كانوا قريبين منه وناظرين إليه
ولأن النصاري يروون بالتواتر أنه بقي بعد الصلب وقبل الموت مدة طويلة بحيث رآه الجمع العظيم في بياض النهار
وذلك يبطل قولكم
الوجه الثاني
روي ان جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في صورة دحية الكلبي
وأن الملائكة يوم بدر تشكلوا بأشكال الأدميين
الوجه الثالث
أن الإنسان ربما يتشبح له عند الخوف الشديد أو الغضب الشديد أو الفكر الشديد صورة لا وجود لها في الخارج وكل ذلك مما يؤكد احتمال الاشتباه
سلمنا صحة دليلكم في التواتر عن الأمور الموجودة فلم قلتم إن خبر التواتر عن الأمور الماضية في القرون الحالية قد وجدت هذه الشروط في كل الطبقات الماضية
قوله في الوجه الأول أهل التواتر في زماننا قد أخبرونا بأن أولئك الذين مضوا كانوا موصوفين بصفات أهل التواتر
قلنا هذا بهت صريح لأن الذين أخبرونا ما أخبرنا كل واحد منهم أن الذين أخبروه كانوا بصفة أهل التواتر وأن الذين أخبروا كل واحد ممن أخبره كانوا كذلك بل الذي يمكن
ادعاؤه عليهم أنهم سمعوا هذا الخبر من أناس كثيرين فأما أن يدعى عليهم ما ذكرتموه فبهت لأن أكثر الفقهاء والنحاة لا يتصورون هذه الدعوى على وجهها فضلا عن العوام فضلا عن أن يقال إنهم علموا ذلك بالضرورة
قوله لو كان حادثا لظهر زمان حدوثه
قلنا لا نسلم أن كل مقالة ظهرت بعد الخفاء فلا بد وأن يشتهر فيما بين الخلق حدوث ظهورها ووقت ظهورها لجواز أن يضع الرجل الواحد مقالة ثم إنه يذكرها لجماعة قليلين ثم كل واحد من أولئك يذكر ذلك الخبر لجماعة أخرى من غير أن يسنده إلى القائل الآول إلى أن يشتهر ذلك الخبر جدا مع أن كل واحد منهم لا يعرف حدوث تلك المقالة ولا زمان حدوثها وبهذا الطريق تحدث الأراجيف بين الناس
وبالجملة فعليهم إقامة الدلالة على فساد هذا الاحتمال
ثم الذي يفيد القطع بصحة ما ذكرنا أن الوقائع الكبار التي وقعت لعظماء الملوك الذين كانوا قبل الإسلام بل كيفية وقائع نوح وإدريس وموسى وعيسى عليهم السلام لم ينقل شيء منها
إلينا نقل الآحاد فضلا عن التواتر مع كونها من الأمور العظام فعلمنا أن وصول الأخبار إلينا غير واجب
فإن قلت ذلك لتطاول مدتها أو لعدم الداعي إلى نقلها
قلت فلا بد من ضبط طول المدة وقصرها
وأيضا
فيلزم أن لا يكون خبر التواتر بوجود نوح وإبراهيم وإدريس وغيرهم مفيدا للعلم لأنه لا يفيد ما لم يثبت استواء الطرفين والواسطة في نقل الرواة وذلك لا يثبت إلا بأنه لو كان موضوعا لاشتهر الواضع وزمان الوضع فإذا لم يجب ذلك عند تطاول المدة لم يفد ذلك الخبر العلم
سلمنا أن ما ذكرته يدل على أن خبر التواتر يفيد العلم لكن معنا ما يبطله من وجوه
الأول
لو أفاد خبر التواتر العلم لأفاد إما علما ضروريا أو نظريا والقسمان باطلان فالقول بالإفادة باطل
إنما قلنا إنه لا يفيد علما ضروريا لأن العلم الضروري هو الذي لا يلزم من وقع الشك في غيره من القضايا وقوعه
فيه وها هنا يلزم من وقوع الشك في غير هذه القضية وقوعه فيها لأنا لو جوزنا أن يكذبوا لا لغرض أو لغرض من رهبة أو رغبة أو لوقوع التباس فإن مع استحضار الشك في هذه المقدمات لم يمكن الجزم بأن الأمر كما أخبروا عنه
وإذا كان كذلك لم يكن هذا العلم ضروريا
ولا جائز أن يكون نظريا لأن النظر في الدليل لا يتأتى للصبيان والمجانين فكان يجب أن لا يحصل لهم العلم لكن الاعتقاد الذي في هذا الباب للعقلاء لا يزيد في القوة على قوة اعتقاد الصبيان والبله فإذا لم يكن اعتقادهم علما فكذا اعتقاد العقلاء
الثاني
أن كون التواتر مفيدا للعلم يتوقف على عدم تطرق اللبس إلى الخبر على ما مر بيانه لكن اللبس يتطرق إليه على ما مر فوجب أن لا يفيد العلم
الثالث لو حصل العلم عقيب التواتر لحصل إما مع الجواز أو مع الوجوب فإن حصل مع جواز أن لا يحصل امتنع القطع بحصوله فلا يمكن القطع بأن التواتر يفيد العلم لا محالة بل يجري حصول العلم عقيب خبر التواتر مجرى حصوله عند سماع صرير الباب ونعيق الغراب وإن حصل مع الوجوب فالمستلزم إما قول كل واحد أو قول المجموع
الأول باطل أما أولا فلأنا نعلم بالضرورة أن قول الواحد لا يفيد العلم
وأما ثانيا فلأن قول كل واحد منهم إذا كان مستقلا بالاستلزام فإن وجدت الأقوال دفعة لزم أن يجتمع على الأثر الواحد مؤثرات مستقلة بالتأثير وهو محال
وإن وجدت على التعاقب فإذا حصل الأثر بالسابق استحال حصول ذلك الأثر بعينه باللاحق لامتناع ايجاد الموجود واستحال
أيضا حصول مثله باللاحق لاستحالة الجمع بين المثلين فيلزم أن يبقى اللاحق خاليا عن التأثير فتكون العلة القطعية منفكة عن المعلول وهو محال
ولا جائز أن يكون المؤثر قول المجموع أما أولا فلان قول كل واحد إن بقي عند الإجتماع كما كان عند الانفراد و لم يحدث عند الاجتماع أمر زائد ألبته فكما لم يكن الاستلزام حاصلا عند الانفراد وجب أن لا يحصل عند الاجتماع
وإن حدث أمر ما إما بزوال أو بالحدوث فإن كان المقتضي لذلك الحدوث قول كل واحد عاد المحذور المذكور
وإن كان المجموع عاد التقسيم المذكور
وإن كان لحدوث أمر آخر لزم التسلسل وأما ثانيا وهو أن المستلزمية نقيض اللامستلزمية التي هي
أمر عدمي فكانت المستلزمية أمرا ثبوتيا فإن كان الموصوف بها هو المجموع لزم حلول الصفة الواحدة في الأشياء الكثيرة وهو محال
وأما ثالثا فلأن التواتر في الأكثر إنما يكون بورود الخبر عقيب الخبر وإذا كان كذلك كان عند حصول كل واحد منهما حال وجود الثاني معدوما فلا يكون للمجموع وجود في زمان أصلا فيستحيل أن يكون المؤثر هو المجموع لأن الشيء ما لم يوجد في نفسه لا يقتضي وجود غيره
وأما رابعا وهو الكلام المشهور في هذا المسألة أن قول كل واحد لما لم يكن مؤثرا وجب أن يكون قول الكل غير مؤثر كما أن كل واحد من الزنج لما لم يكن أبيض استحال كون الكل أبيض
الوجه الرابع
في استحالة أن يكون خبر التواتر مستلزما للعلم لأن المستلزم إما آحاد الحروف وهو باطل أو المجموع وهو محال لأن المجموع لا وجود له وما لا وجود له استحال أن يستلزم شيئا اخر فإن قلت الموجب هو الحرف الأخير بشرط وجود سائر الحروف قبله أو بشرط مسبوقية الحرف الأخير بسائر الحروف
قلت الشرط لا بد من حصوله حال حصول المشروط والحروف السابقة غير حاصلة حال حصول الحرف الأخير
وعن الثاني
أن مسبوقية الشيء بغيره لا تكون صفة وإلا كانت صفة حادثة فتكون مسبوقتيها بالغير صفة أخرى ولزم التسلسل
وإذا كانت المسبوقية أمرا عدميا استحال أن يكون جزء العلة أو شرطها
أما الذين سلموا أن خبر التواتر عن الأمور الموجودة يفيد العلم لكنهم منعوا من كون التواتر عن الأمور الماضية مفيدا للعلم فقد احتجوا بأن التواتر عن الأمور الماضية وقع عن أمور باطلة فوجب أن لا يكون حجة
بيان الأول
أن اليهود
والنصارى والمجوس والمانوية على كثرة كل فرقة منهم وتفرقهم في الشرق والغرب يخبرون عن أمور هي باطلة قطعا عند المسلمين وذلك يقتضي القدح في التواتر
فإن قلت شرط التواتر استواء الطرفين الواسطة وهو غير حاصل في هذه الفرق لأن اليهود قل عددهم في زمان بختنصر والنصاري كانوا قليلين في الابتداء وكذا القول في المجوس والمانوية
قلت صدقتم حيث قلتم لا بد من استواء الطرفين والواسطة لكن الطريق إليه إما العقل أو النقل أو ما هو مركب منهما
والعقل المحض لا يكفي
وأما النقل فإما من الواحد أو من الجمع وقول الواحد إنما يفيد لو كان معصوما وهو مفقود في زماننا
وأما الجمع فهو أن يقال إن أهل التواتر في زماننا على كثرتهم يخبرون إنهم كانوا كذلك أبدا لكن كما أن أهل الإسلام يدعون ذلك فهذه الفرق الأخرى تدعي ذلك فليس تصديق إحداهما وتكذيب الأخرى أولى من العكس
وأما المركب منهما فهو أن يقال لو كان خبرا موضوعا لعرفنا أن الأمر كذلك وقد عرفت ضعف هذه الطريقة
ثم إن جميع هذه الفرق يصححون قولهم بمثل هذه الطريقة فليس قبول أحد القولين أولى من الآخر
فأما الذي يقال إن بختنصر قتل اليهود حتى لم يبق منهم عدد أهل التواتر
قلنا هذا محال لأن الأمة العظيمة المتفرقة في الشرق والغرب يستحيل قتلها إلى هذا الحد
وأما النصارى فلو لم يكونوا بالغين في أول الأمر إلى حد التواتر لم يكن شرعه حجة إلى زمان ظهور محمد صلى الله عليه و سلم لكنه باطل باتفاق المسلمين
وها هنا وجوه أخر من المعارضات مذكورة في كتاب النهاية
فهذا تمام الاعتراضات
واعلم أن بعض هذه الأسئلة والمعارضات لا شك أن فسادها أظهر من صحتها لكن ذلك إنما يكفي في ادعاء الظن القوي لا في ادعاء اليقين التام وكان غرضنا من الإطناب في هذه الأسئلة إن الذي قاله أبو الحسين من أن الاستدلال بخبر النوادر على صدق المخبرين أمر سهل هين مقرر في عقول البله والصبيان ليس بصواب بل لما فتحنا باب المناظرة دق الكلام ولا يتم المقصود إلا بالجواب القاطع عن كل هذه الإشكالات وذلك لو أمكن فإنما يمكن بعد تدقيقات في النظر عظيمة ومن البين لكل عاقل أن علمه بوجود مكة ومحمد صلى الله عليه و سلم اظهر من علمه بصحة هذه الدلالة وإبطال ما فيها من الأقسام سوى القسم المطلوب وبناء الواضح على الخفي غير جائز فظهر أن الحق ما ذهبنا اليه من أن هذا العلم ضروري
وحينئذ لا نحتاج إلى الخوض في الجواب عن هذه الأسئلة لأن
التشكيك في الضروريات لا يستحق الجواب
المسألة الخامسة في شرائط التواتر
اعلم أن هذه الأخبار التي نعلم مخبرها باضطرار الحجة علينا فيها هو العلم ولا حاجة بنا إلى اعتبار حال المخبرين بل يجب أن يعتبر السامع حال نفسه فإذا حصل له العلم بمخبر تلك الأخبار صار محجوجا بها وإلا فالحجة عنه زائلة
ثم إنه بعد وقوع العلم بمخبر خبرهم صح أن نبحث عن أحوالهم فنقول لو لم يكونوا على هذه الصفة لما وقع لنا العلم بخبرهم
وأعلم أن ها هنا أمور معتبرة في كون التواتر مفيدا للعلم وأمورا ظن أنها معتبرة مع أنها في الحقيقة غير معتبرة
أما القسم الأول فنقول إن تلك الأمور إما أن تكون راجعة إلى السامعين أو إلى المخبرين
أما الأمور الراجعة إلى السامعين فأمران
الأول
أن لا يكون السامع عالما بما أخبر به اضطرارا لأن تحصيل الحاصل محال وتحصيل مثل الحاصل أيضا محال وتحصيل التقوية أيضا محال لأن العلم الضروري أيضا يستحيل أن يصير أقوى مما كان
مثاله
إن كان العلم حاصلا بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان لم يكن للاخبار عنه تأثير في العلم به و الثاني
قال الشريف المرتضي يجب أن لا يكون السامع قد سيق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفى موجب الخبر وهذا الشرط إنما اعتبره الشريف لأن عنده الخبر عن النص على إمامة علي رضي الله عنه
متواتر ثم لم يحصل العلم به لبعض السامعين فقال ذلك لأنهم اعتقدوا نفي النص لشبهة
واحتج عليه
بأن حصول العلم عقيب خبر التواتر إذا كان بالعادة جاز أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال فيحصل للسامع إذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم قبل ذلك الحكم ولا يحصل له إذا اعتقد ذلك
فإن قلت يلزمكم عليه أن تجوزوا صدق من أخبركم بأنه لم يعلم وجود البلدان الكبار والحوادث العظام بالأخبار المتواترة لأجل شبهة اعتقدها في نفي تلك الأشياء
قلت إنه لا داعي يدعو العقلاء إلى سبق اعتقاد نفي هذه الأمور ولا شبهة في نفي تلك الأشياء أصلا
أما ما يرجع إلى المخبرين فأمران
الأول
أن يكونوا مضطرين إلى ما أخبروا عنه لأن غير الضروري يجوز دخول الالتباس فيه فلا جرم لا يحصل العلم به ولذلك فإن المسلمين يخبرون اليهود بنبوة محمد صلى الله عليه و سلم ولا يحصل لهم العلم بها
الثاني
العدد وفيه مسائل
المسألة الأولى
قال القاضي أبو بكر اعلم أن قول الأربعة لا يفيد العلم أصلا وأتوقف في قول الخمسة
واحتج عليه
بأنه لو وقع العلم بخبر أربعة صادقين لوقع بخبر كل أربعة صادقين وهذا باطل فذاك مثله
بيان الملازمة أنه لو وقع العلم بقول أربعة ولا يقع بقول مثلهم مع تساوي الأحوال والقائلين والسامعين في جميع الشروط لم يمتنع أن تخبرنا قافلة الحاج بوجود مكة فنعرفها ثم هم بأعيانهم يخبروننا بوجود المدينة فلا نعرفها ولما لم يجز ذلك صح قولنا
وإنما قلنا إن العلم لا يحصل بخبر كل أربعة لأنه لو وقع العلم بخبر كل أربعة إذا كانوا صادقين لكان يجب إذا شهد أربعة انهم شاهدوا فلانا على الزنا أن يستغنى القاضي عن التزكية لأنهم إذا كانوا صادقين وجب أن يحصل له العلم بقولهم وحينئذ يستغنى عن التزكية
وإن لم يحصل له العلم بقولهم قطع بكونهم كاذبين قطعا وحينئذ يسغنى أيضا عن التزكية ولما لم يكن كذلك بل
أجمعوا على وجوب إقامة الحد وإن لم يضطر القاضي إلى صدقهم علمنا أن العلم لا يحصل بخبر الأربعة فإن قيل الملازمة ممنوعة
قوله لو وقع العلم بخبر أربعة صادقين ولا يقع بخبر أربعة صادقين اخرين لزم كذا وكذا
قلنا لم قلت إنه يلزم ذلك
بيانه
أن العلم بمخبر الأخبار حاصل عن فعل الله تعالى عندكم وإذا كان كذلك جاز منه تعالى أن يخلق ذلك العلم عند خبر أربعة ولا يخلقه عند خبر أربعة أخرى ولا تجري العادة في ذلك على طريقة واحدة وإن كانت العادة في أخبار الجماعات العظيمة جارية على طريقة واحدة كما أن التكرار على البيت الواحد ألف مرة سبب لحفظه في العادة المطردة
وأما تكراره مرتين أو ثلاثا فقد يكون سببا لحفظه وقد لا يكون والعادة فيه مختلفة
سلمنا أنه يلزم من اطراد العادة في شيء اطرادها في مثله فلم قلت يلزم من حصول العلم عند رواية أربعة حصوله عند شهادة أربعة
بيانه
أن الشهادة وإن كانت خبرا في المعنى لكن لفظ الشهادة مخالف للفظ الخبر الذي ليس بشهادة فلم لا يجوز أن يجري الله تعالى عادته بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ الشهادة ولا يفعله عند لفظ الشهادة وإن كان الكل خبرا
سلمنا أن التفاوت بين لفظ الشهادة وبين لفظ الخبر الذي ليس بشهادة غير معتبر فلم لا يجوز أن يقال لما كان من شرط الشهادة أن يجتمع المخبرون عند الشهادة وذلك الاجتماع يوهم الاتفاق على الكذب فلا جرم لم يفد العلم
بخلاف الرواية
سلمنا أن ما ذكرته يوجب الجزم بأن قول الأربعة لا يفيد العلم لكنه يوجب الجزم بأن قول الخمسة لا يفيد أيضا لأن قول الخمسة لو أمكن أن يفيد فإذا شهدوا فإن كانوا صادقين وجب أن يفيد العلم الضروري
وإن لم يحصل العلم بصدقهم وجب القطع بكذبهم فهذا يقتضي أن تكون الخمسة كالأربعة في القطع بأنها لا تفيد
سلمنا ذلك لكن يلزمكم أن تقطعوا بأن عدد أهل القسامة لا يفيد العلم لعين ما تقدم ذكره في الخمسة
والجواب
أما الأسئة الثلاثة الأولى فواردة ولا جواب عنها
وأما المعارضة بقول الخمسة فالجواب أنه لا يمتنع أن يقع العلم بخبر خمسة والحاكم إنما لم يعلم صدق هؤلاء الخمسة وإن وجب عليه إقامة الحد لجواز أن يكون أربعة منهم شاهدوا ذلك والخامس ما شاهده فلزم إقامة الحد بقول أربعة منهم وإن لم يعرفهم بأعيانهم وكان الخامس كاذبا فلا جرم وجب عليه البحث عن أحوالهم
وهذا بخلاف الأربعة فإنه إذا لم يحصل العلم بقولهم وجب أن يكون واحد منهم كاذبا
وبهذا التقدير تسقط الحجة بقولهم ولزم على الحاكم
رد قولهم وإقامة الحد عليهم فظهر الفرق
واعلم أن هذا الجواب يقتضي القطع بكذب واحد من الخمسة أو القطع بأن قول الخمسة لا يفيد العلم أصلا أو القول بأنه لا يلزم من كون قول الخمسة مفيدا للعلم أن يكون قول كل خمسة مفيدا للعلم
قوله يلزمكم أن تقطعوا بأنه لا يقع العلم بخبر أهل القسامة
قلنا أهل العراق يقولون يحلف خمسون من المدعى عليهم كل واحد منهم على أنه ما قتل ولا عرف قاتلا فكل واحد منهم يخبر عن غير ما يخبر عنه الآخر
وعند الشافعي رضي الله عنه يحلف خمسون من المدعين كل واحد منهم بحسب ظنه فخبر كل واحد منهم
غير خبر الآخر
المسألة الثانية
الحق أن العدد الذي يفيد قولهم العلم غير معلوم فإنه لا عدد يفرض إلا وهو غير مستبعد في العقل صدور الكذب عنهم وإن الناقص عنهم بواحد أو الزائد عليهم بواحد لا يتميز عنهم في جواز الإقدام على الكذب
ومنهم من اعتبر فيه عددا معينا وذكروا وجوها
أحدها
الاثنا عشر لقوله تعالى وبعثنا منهم أثني عشر نقيبا
وثانيها
العشرون وهو قول أبي الهذيل قال لقوله تعالى إن يكن منكم عشرون
صابرون يغلبوا مائتين أوجب الجهاد على العشرين وإنما خصهم بالجهاد لأنهم إذا أخبروا حصل العلم بصدقهم
وثالثها
الأربعون لقوله تعالى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين نزلت في
الأربعين
ورابعها
السبعون لقول تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا
وخامسها
ثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل بدر
وسادسها
عدد بيعة الرضوان
واعلم أن كل ذلك تقييدات لا تعلق للمسألة بها
فإن قلت إذا جعلتم العلم معرفا لكمال العدد تعذر عليكم الاستدلال به على الخصم
قلت إنا لا نستدل ألبتة على حصول العلم بالخبر المتواتر بل المرجع فيه إلى الوجدان كما تقدم بيانه
فهذه هي الشرائط المعتبرة في خبر التواتر إذا أخبر المخبرون عن المشاهدة
فأما إذا نقلوا عن قوم اخرين فالواجب حصول هذه الشرائط في كل تلك الطبقات ويعبر عن ذلك بوجوب استواء الطرفين والواسطة
و أما القسم الثاني وهي الشرائط التي اعتبرها قوم مع انها غير معتبرة فأربعة
الأول أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد وهو باطل لأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن عن المنارة فيما بين الخلق لكان إخبارهم مفيدا للعلم
الثاني
أن لا يكونوا على دين واحد وهذا شرط اعتبره اليهود وهو باطل لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم سواء كانوا على دين واحد أو على أديان وإن ارتفعت حصل العلم كيف كانوا
الثالث
أن لا يكونوا من نسب واحد ولا من بلد واحد والقول فيه ما تقدم
الرابع
شرط ابن الرواندي وجود المعصوم في المخبرين لئلا يتفقوا
على الكذب وهو باطل لأن المفيد حينئذ قول المعصوم لا خير أهل التواتر
المسألة الثالثة
في خبر التواتر من جهة المعنى
مثاله
أن يروي واحد أن حاتما وهب عشرة من العبيد واخبر اخر أنه وهب خمسة من الإبل وأخبر اخر أنه وهب عشرين ثوبا ولا يزال يروي كل واحد منهم من هذا الخبر شيئا فهذه الأخبار تدل على سخاوة حاتم من وجهين
الأول
أن هذه الجزئيات مشتركة في كلي واحد وهو كونه سخيا والراوي للجزئي بالمطابقة راو للكلي المشترك فيه
بالتصمت فإذا بلغوا حد التواتر صار ذلك الكلي مرويا بالتواتر
الثاني أن نقول هؤلاء الرواة بأسرهم لم يكذبوا بل لا بد وأن يكون الواحد منهم صادقا وإذا كان كذلك فقد صدق جزئي واحد من هذه الجزئيات المروية ومتى صدق واحد منها ثبت كونه سخيا
والوجه الأول أقوى لأن المرة الواحدة لا تثبت السخاوة
الباب الثاني فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
القول في الطرق الصحيحة وهي ثمانية
الأولالخبر الذي عرف وجود مخبره بالضرورة
الثاني
الخبر الذي عرف وجود مخبره بالاستدلال
الثالث
خبر الله تعالى صدق باتفاق أرباب الملل والأديان ولكنهم اختلفوا في الدلالة عليه بحسب اختلافهم في مسألتي الحسن والقبح والمخلوق
أما أصحابنا فقد قال الغزالي رحمة الله يدل عليه دليلات أقواهما إخبار الرسول صلى الله عليه و سلم عن امتناع الكذب على الله تعالى
والثاني
أن كلامه تعالى قائم بذاته ويستحيل الكذب في كلام النفس على من يستحيل عليه الجهل إذ الخبر يقوم بالنفس على
وفق العلم والجهل على الله تعالى محال
ولقائل أن يعترض على الأول بأن العلم بصدق الرسول موقوف على دلالة المعجزة على صدقه صلى الله عليه و سلم وذلك إنما كان لأن المعجز قائم مقام التصديق بالقول
وإذا كان صدق الرسول صلى الله عليه و سلم مستفادا من تصديق الله تعالى إياه وذلك إنما يدل أن لو ثبت أن الله صادق إذا لو جاز الكذب عليه لم يلزم من تصديقه للنبي صلى الله عليه و سلم كونه صادقا
فإذن العلم بصدق الرسول صلى الله عليه و سلم موقوف على العلم بصدق الله تعالى فلو استفدنا العلم بصدق الله تعالى من صدق الرسول صلى الله عليه و سلم للزم الدور
فإن قلت لا نسلم أن دلالة تصديق الله تعالى للرسول على كونه صادقا يتوقف على العلم بكون الله تعالى صادقا لأن قوله للشخص المعين أنت رسولي جار مجرى قول الرجل لغيره أنت وكيلي فإن هذه الصيغة وإن كانت إخبارا
في الأصل لكنها إنشاء في المعنى والإنشاء لا يتطرق إليه التصديق والتكذيب
وإذا كان كذلك فقول الله تعالى للرجل المعين أنت رسولي يدل على رسالته سواء قدر أن الله تعالى صادق أو لم يقدر ذلك وعلى هذا ينقطع الدور
قلت هب أن قوله في حق الرسول المعين إنه رسولي إنشاء ليس يحتمل الصدق والكذب لكن الإنشاء تأثيره في الأحكام الوضعية لا في الأمور الحقيقية
وإذا كان كذلك لم يلزم من قول الله تعالى له أنت رسولي أن يكون الرسول صادقا في كل ما يقول لأن كون ذلك الرجل صادقا أمر حقيقي والأمور الحقيقية لا تختلف باختلاف الجعل الشرعي
فإذن لا طريق إلى معرفة كون الرسول صادقا فيما يخبر عنه إلا من قبل كون الله تعالى صادقا وحينئذ يلزم الدور
وعلى الثاني
أن البحث في أصول الفقه غير متعلق بالكلام القائم بذات الله تعالى الذي ليس بحرف ولا صوت بل عن الكلام المسموع الذي هو الأصوات المقطعة
وإذا كان كذلك لم يلزم من كون الكلام القائم بذاته تعالى صدقا كون هذا المسموع صدقا فلعمنا أن هذه الحجة مغالطة
وأيضا يقال
لم قلت إن الكلام القائم بذاته تعالى صدق
قوله لأنه تعالى ليس بجاهل ومن لا يكون جاهلا استحال أن يخبر بالكلام النفساني خبرا كاذبا
قلنا هذه القضية غير بديهية فما البرهان
و أما المعتزلة فهم ظنوا أن هذا البحث ظاهر على قواعدهم فقالوا الكذب قبيح والله تعالى لا يفعل القبيح
والاعتراض أن نقول إن البحث عن أن الله تعالى لا يصح عليه الكذب يجب أن يكون مسبوقا بالبحث عن ماهية الكذب لأن التصديق مسبوق بالتصور فنقول
أما أن يكون المراد من الكذب الكلام الذي لا يكون مطابقا للمخبر عنه في الظاهر سواء كان بحيث لو أضمر فيه زيادة أو نقصان أو تغيير صح
وإما أن يكون المراد منه الكلام الذي لا يكون مطابقا للمخبر عنه في الظاهر ولا يمكن أن يضمر فيه ما عنده يصير مطابقا
فإن أردتم بالكذب المعنى الأول لم يمكنكم أن تحكموا بقبحه وبأنه لا يجوز ذلك على الله تعالى لأن أكثر العمومات في كتاب الله مخصوص
وإذا كان كذلك لم يكن ظاهر العموم مطابقا للمخبر عنه
وكذا الحذف والإضمار واقعان باتفاق أهل الإسلام في كتاب الله تعالى حتى إنه حاصل في أوله فإن الناس اختلفوا في معنى بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من قدم المضمر وهو الأمر أو الخبر ومنهم من أخره وكذا الحمد لله رب العالمين
قالوا معناه قولوا الحمد لله فالإضمار متفق عليه
ولأن المعتزلة اتفقوا على حسن المعاريض على أنه لا معنى لها إلا الخبر الذي يكون ظاهره كذبا ولكنه عند إضمار شرط خاص وقيد خاص يكون صدقا
وإذا كان كذلك ثبت أنه لا يمكن تفسير الكذب الممتنع على الله تعالى بالوجه الأول
وأما التفسير الثاني فنقول نسلم أنه قبيح بتقدير الوقوع ولكنه غير ممكن الوجود لأنه لا خبر يفرض كونه كذبا إلا وهو بحال متى أضمرنا فيه زيادة أو نقصانا صار صدقا
وعلى هذا التقدير يرتفع الأمان عن جميع ظواهر الكتاب والسنة
فإن قلت لو كان مراد الله غير ظواهرها لوجب أن يبينها وإلا كان ذلك تلبيسا وهو غير جائز
ولأنا لو جوزنا ذلك لم يكن في كلام الله تعالى فائدة فيكون عبثا وهو غير جائز
قلت الجواب عن الأول
ما الذي تريد بكونه تلبيسا
إن عنيت به أنه تعالى فعلا يحتمل إلا التجهيل والتلبيس فهذا غير لازم لأنه تعالى لما قرر في عقول المكلفين أن اللفظ المطلق جائز أن يذكر ويراد به المقيد بقيد غير مذكور معه ثم أكد ذلك بأن بين للمكلف وقوع ذلك في أكثر الآيات والأخبار فلو قطع المكلف بمقتضى الظاهر كان وقوع المكلف في ذلك الجهل من قبل نفسه لا من قبل الله تعالى حيث قطع لا في موضع القطع وهذا كما يقال في إنزل المتشابهات فإنها وإن كانت موهمة للجهل إلا أنها لما لم تكن متعينة لظواهرها بل كان فيها احتمال لغير تلك الظواهر الباطلة لا جرم كان القطع بذلك تقصيرا من المكلف لا تلبيسا من الله تعالى
وعن الثاني
أنا لو ساعدنا على أنه لا بد لله تعالى في كل فعل من غرض معين لكن لم قلت إنه لا غرض من تلك الظواهر إلا منهم معانيها الظاهرة أليس أنه ليس الغرض من إنزال المتشابهات فهم ظواهرها بل الغرض من إنزالها أمور أخرى فلم لا يجوز أن يكون الأمر ها هنا كذلك
فإن قلت جواز إنزال المتشابهات مشروط بأن يكون الدليل قائما على امتناع ما أشعر به ظاهر اللفظ فما لم يتحقق هذا الشرط لم يكن إنزال المتشابهات جائزا
قلت لا شك أن إنزال المتشابه غير مشروط بأن يكون الدليل المبطل للظاهر معلوما للسامع بل هو مشروط بأن يكون ذلك الدليل موجودا في نفسه سواء علمه السامع لذلك المتشابه أو لم يعلمه
وإذا كان كذلك فما لم يعلم السامع أنه ليس في نفس الأمر دليل
مبطل لذلك الظاهر لا يمكنه اجراؤه على ظاهره
ثم لا يكفي في العلم بعدم الدلل العقلي المبطل للظاهر عدم العلم بهذا الدليل المبطل لأنا بينا في الكتب الكلامية أنه لا يلزم من عدم العلم بالشيء العلم بعدم الشيء
إذا كان كذلك فلا ظاهر نسمعه إلا ويجوز أن يكون هناك دليل عقلي أو نقلي يمنع من حمله على ظاهره وإذا كان هذا التجويز قائما لم يقع الوثوق بشيء من الظواهر على مذهب المعتزلة ألبتة
ولما بينا ضعف هذه الطرق فالذي نعول عليه في المسألة أن الصادق أكمل من الكاذب والعلم به ضروري فلو كان الله جده وتقدست اسماؤه كاذبا لكان الواحد منا حال كونه صادقا أكمل وأفضل من الله تعالى وذلك معلوم البطلان بالضرورة فوجب القطع بكون الله تعالى صادقا وهو المطلوب
الرابع
خبر الرسول صلى الله عليه و سلم قال الغزالي رحمه الله دليل صدقه دلالة المعجزة على صدقه مع استحالة ظهور على يد الكذابين لأن ذلك لو كان ممكنا لعجز الله تعالى عن تصديق رسله ولقائل أن يقول اذا كان يلزم من اقتدار الله تعالى على إظهار المعجز على يد الكاذب عجزه تعالى عن تصديق الرسول فكذا يلزم من الحكم بعدم اقتداره عليه عجزه فلم كان نفي أحد العجزين عنه أولى من الآخر وأيضا إذا فرضنا أن الله تعالى قادر على إقامة المعجزة على يد الكاذب فمع هذا الفرض إما أن يكون تصديق الرسول ممكنا أو لا يكون فإن أمكن بطل قوله إنه يلزم من قدرة الله تعالى على
إظهار المعجز على يد الكاذب عجزه عن تصديق الرسول وإن لم يكن ذلك ممكنا لم يلزم إنما يتحقق عما يصح أن يكون مقدورا في نفسه ألا ترى أن الله لا يوصف بالعجز عن خلق نفسه
وأيضا فإذا استحال يقدر الله تعالى على تصديق رسله إلا استحال منه إظهار المعجزة على يد الكاذب وجب أن ينظر أولا أن ذلك هل هو محال أم لا وأن لا يستدل باقتداره على تصديق الرسل على عدم قدرته على إظهاره على يد الكاذب لأن ذلك تصحيح الأصل بالفرع وهو دور
وأيضا إذا تأملنا علمنا أن ذلك غير ممتنع لأن قلب العصا حية لما كان مقدورا لله تعالى وممكنا في نفسه لم يقبح من الله تعالى فعله في شيء من الأوقات و بشيء من الجهات
فبأن قال زيد كاذبا أنا رسول الله يستحيل أن ينقلب الممكن ممتنعا والمقدور معجوزا سلمنا ذلك لكن المعجز يدل على كونه صادقا في ادعاء الرسالة فقط أو على صدقه في كل ما أخبر عنه الأول مسلم والثاني ممنوع
بيانه
أن يكون إذا ادعى الرسالة وأقام المعجز كان المعجز دالا على صدقه فيما ادعاه وهو كونه رسولا لا على صدقه في غير ما ادعاه فإن الرسول ما ادعى كونه صادقا في جميع الأمور أو لا يعلم أنه ادعى الصدق في كل الأمور فإذن هذا المطلوب لا يتم إلا بإقامة الدلالة على أنه ادعى كونه صادقا في جميع ما يخبر عنه ثم أقام المعجزة عليه وذلك لا يكفي فيه قيام المعجز على ادعاء الرسالة وكيف والعلماء اختلفوا في جواز الصغائر على الأنبياء بل جوز بعضهم الكبائر عليهم واتفقوا على جواز السهو والنسيان
بل الصواب أن يقال إن ظهر المعجز عقيب ادعاء الصدق في كل ما يخبر عنه وجب الجزم بتصديقه في الكل وإلا ففي القدر المدعى فقط
الخامس
خبر كل الأمة عن الشيء يجب أن يكون صدقا لقيام الدلالة على أن الإجماع حجة
السادس
خبر الجمع العظيم عن الصفات القائمة بقلوبهم من الشهوة والنفرة لا يجوز أن يكون كذبا
وأيضا
الجمع العظيم البالغ إلى حد التواتر إذا أخبر واحد منهم عن شيء غير ما أخبر عنه صاحه ! فلا بد وأن يقع فيها ما يكون صدقا ولذلك نقطع بأن الأخبار المروية عنه صلى الله عليه و سلم على سبيل الآحاد ما هو قوله وإن كنا لا نعرف ذلك بعينه
السابع
اختلفوا في أن القرائن هل تدل على صدق الخبر أم لا فذهب النظام وإمام الحرمين والغزالي إليه والباقون أنكروه
احتج المنكرون بأمور
أولها أن الخبر مع القرائن التي يذكرها النظام لو أفاد العلم لما جاز انكشافه عن الباطل لكن قد ينكشف عنه لأنا قد علمنا أن الخبر عن موت إنسان مع القرائن التي يذكرها النظام من البكاء عليه والصراخ وإحضار الجنازة والأكفان قد ينكشف عن الباطل فيقال انه أغمى عليه أو لحقته سكتة أو أظهر ذلك ليعتقد السلطان موته فلا يقتله فثبت أن هذه القرائن لا تفيد العلم
الثاني
لو كانت القرائن هي المفيدة للعلم لجاز أن لا يقع العلم عند خبر
التواتر لعدم تلك القرائن ولما لم يجز ذلك بطل قوله
الثالث
لو وجب العلم عند خبر واحد لوجب ذلك عند خبر كل واحد كما أن الخبر المتواتر لما اقتضاه في موضع اقتضاه في كل موضع
والجواب عن الأول
أن الذي ذكرتموه لا يدل إلا على أن ذلك القدر من القرائن لا يفيد العلم ولا يلزم منه أن لا يحصل العلم بشيء من القرائن لأن القدح في صورة خاصة لا يقتضي القدح في كل الصور
وعن الثاني
أن النظام يلتزم ويقول خبر التواتر ما لم تحصل فيه القرائن لم يفد العلم ومن تلك القرائن أن يعلم أنه ما جمعهم جامع من رغبة أو رهبة أو التباس سلمنا ذلك لكن لا يلزم من قولنا القرائن تفيد العلم قولنا
إنها هي المفيدة وبتقدير أن تكون هي المفيدة فلم قلت يجوز انفكاك خبر التواتر عنها
وعن الثالث
أن خبر الواحد إنما يفيد العلم لا لذاته فقط بل بمجموع القرائن فمتى حصل ذلك المجموع مع أي خبر كان أفاد العلم
وأيضا
فالعلم الحاصل عقيب خبر التواتر عندكم حاصل بالعادة فيجوز أيضا أن يكون حصوله عقيب القرائن بالعادة وإذا كان كذلك جاز أن تكون هذه العادة مختلفة وإن كانت مطردة في التواتر
والمختار
أن القرينة قد تفيد العلم إلا القرائن لا تفي العبارات بوصفها فقد تحصل أمور يعلم بالضرورة عند العلم بها كون الشخص خجلا أو وجلا مع أنا لو حاولنا التعبير عن جميع تلك الأمور لعجزنا عنه والإنسان إذا أخبر عن كونه عطشانا فقد يظهر
على وجهه ولسانه من أمارات العطش ما يفيد العلم بكونه صادقا والمريض إذا أخبر عن ألم في بعض أعضائه مع أنه يصيح وترى عليه علامات ذلك الألم ثم إن الطبيب يعالجه بعلاج لو لم يكن المريض صادقا في قوله لكان ذلك العلاج قاتلا له فها هنا يحصل العلم بصدقه
وبالجملة فكل من استقرأ العرف عرف أن مستند اليقين في الأخبار ليس إلا القرائن فثبت أن الذي قاله النظام حق
القول في الطرق الفاسدة
وهي خمسةالأول
إذا أخبر واحد بحضرة الرسول صلى الله عليه و سلم عن شيء والرسول ترك الإنكار عليه قال بعضهم ذلك يدل على كون ذلك الخبر صدقا والحق أن يقال ذلك الخبر إما أن يكون خبرا عن أمر يتعلق بالدين أو بالدنيا فإن كان عن الدين فسكوته عليه الصلاة و السلام عن الإنكار يدل على صدقه لكن بشرطين
أحدهما
أن لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم
والثاني
أن يجوز تغير ذلك الحكم عما بينه فيما قبل
وإنما وجب اعتبار هذين الشرطين لأن بيان الحكم لو تقدم وأمنا عدم تغيره كان فيما سبق من البيان ما يغني عن استئناف البيان ولهذا لا يلزمه عليه الصلاة و السلام تجديد الإنكار حالا بعد حال على الكفار
وأما القسم الثاني وهو الخبر عن أمر متعلق بالدنيا فسكوته عليه الصلاة و السلام يدل على الصدق بأحد شرطين
أحدهما
أن يستشهد بالنبي صلى الله عليه و سلم ويدعي عليه علمه بالمخبر عنه
وثانيهما
أن يعلم الحاضرون علم النبي صلى الله عليه و سلم بتلك القصة ففي كل واحد من هذين الوجهين يجب صدق الخبر إذ سكوت الرسول صلى الله عليه و سلم ها هنا يوهم التصديق فلو كان المخبر كاذبا لكان الرسول صلى الله عليه و سلم قد أوهم تصديقه وأنه غير جائز وأما إذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يعلم
المخبر عنه أو جوزنا ذلك لم يلزم حينئذ من السكوت عن التكذيب حصول التصديق لأنه عليه الصلاة و السلام يجوز سكوته لاحتمال كونه متوقفا في الأمر
الثاني
قالوا إذا أخبر الواحد بحضرة جماعة كثيرة عن شيء بحيث لو كان كذبا لما سكتوا عن التكذيب كان ذلك دليلا على صدقه فيه لأنهم إما أن يكونوا سكتوا مع علمهم بكذبه أو لا مع علمهم بكذبه
والأول باطل لأن الداعي إلى التكذيب قائم والصارف زائل ومع حصول هذين الشرطين يجب الفعل فلما لم يوجب دل على أنهم لم يعلموا كذبه
وإنما قلنا إن الداعي حاصل لأن من استشهد على خبر كذب فأراد الصبر على التكذيب وجد من نفسه مشقة على ذلك الصبر وذلك يدل على حصول الداعي
وأما زوال الصارف فإن ذلك الصارف إما رغبة أو
رهبة والجمع العظيم لا يعمهم من الرغبة أو الرهبة ما يحملهم على كتمان ما يعلمونه ولهذا لا يجتمعون على كتمان الرخص والغلاء العظيمين
فأما القسم الثاني وهو أن يقال سكتوا لعدم علمهم بكذب القائل فباطل لأنه يبعد عن الجمع العظيم أن لا يطلع واحد منهم عليه
واعلم أن هذا الطريق لا يفيد اليقين بل الظن لأنه لا يمكنا القطع بامتناع اشتراك الجماعة الذين حضروا في رغبة أو رهبة مانعة من السكوت
وإن سلمناه لكن لا يستبعد غفلة الحاضرين عن معرفة كونه كذبا إذ ربما لم يتعلق لهم به غرض فلم يبحثوا عنه
الثالث
زعم أبو هاشم والكرخي وتلميذهما أبو عبد الله البصري أن الإجماع على العمل بموجب الخبر يدل على صحة الخبر وهذا باطل من وجهين
أحدهما
أن عمل كل الأمة بموجب الخبر لا يتوقف على قطعهم بصحة ذلك الخبر فوجب أن لا يدل على صحة ذلك الخبر
أما الأول
فلأن العمل بخبر الواحد واجب في حق الكل فلا يكون عملهم به متوقفا على القطع به
وأما الثاني
فلانه لما لم يتوقف عليه لم يلزم من ثبوته ثبوته
الثاني أن علمهم بمقتضى ذلك الخبر يجوز أن يكون لدليل اخر لاحتمال قيام الأدلة الكثيرة على المدلول الواحد
و احتجوا
بأن المعلوم من عادة السلف فيما لم يقطعوا بصحته أن يرد مدلوله بعضهم ويقبله الآخرون
والجواب
هذه العادة ممنوعة بدليل اتفاقهم على حكم المجوس بخبر عبد الرحمن
الرابع
قال بضع الزيدية بقاء النقل مع ترفر الدواعي على إبطاله الدواعي على إبطاله يدل على صحة الخبر كخبر الغدير والمنزلة فإنه سلم نقلهما في زمان بني أمية مع توفر دواعيهم على ابطالهما
وهذا أيضا ليس بشيء لاحتمال أنه كان من باب الآحاد أولا ثم اشتهر فيما بين الناس بحيث عجز العدو عن إخفائه
ولأن الصوارف من جهة بني أمية وإن حصلت لكن الدواعي من جهة الشيعة حصلت
ولأن الناس إذا منعوا من إفشاء فضيلة إنسان كانت محبتهم
له وحرصهم على ذكر مناقبه أشد مما إذا لم يمنعوا
الخامس
اعتمد كثير من الفقهاء والمتكلمين في تصحيح خبر الإجماع وأمثاله بأن الأمة فيه على قولين
منهم من احتج به ومنهم من اشتغل بتأويله وذلك يدل على اتفاقهم على قبوله
وهو ضعيف أيضا لاحتمال أن يقال إنهم قبلوه كما يقبل خبر الواحد
ويمكن أن يجاب عنه بأن خبر الواحد يقبل في العمليات لا في العلميات وهذه المسألة علمية فلما قبلوا هذا الخبر فيها دل ذلك على اعتقادهم في صحته
والجواب
لا نسلم أن كل الأمة قبلوه بل كل من لم يحتج به في الإجماع طعن فيه بأنه من باب الآحاد فلا يجوز التمسك به في مسألة علمية بل هب أنهم ما طعنوا فيه على التفصيل لكن لا يلزم من عدم الطعن من جهة واحدة عدم الطعن مطلقا
الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا
وهو أربعةالأول
الخبر الذي ينافي مخبره وجود ما علم بالضرورة سواء كان المعلوم بالضرورة حسيا أو وجدانيا أو بديهيا
ومن هذا الباب قول القائل الذي لم يكذب قط أنا كاذب فهذا الخبر كذب لأن المخبر عنه بكونه كاذبا إما أن تكون الأخبار التي وجدت قبل هذا الخبر أو هذا الخبر
والأول باطل لأن تلك الأخبار ما كانت كذبا فإخباره عن نفسه بكونه كاذبا فيها كذب
والثاني باطل لأن الخبر عن الشيء يتأخر في الرتبة عن المخبر عنه فإن جعلنا الخبر عين المخبر عنه لزم تأخر الشيء عن نفسه في الرتبة وهو محال
الثاني
الخبر الذي يكون مخبره على خلاف الدليل القاطع
ثم ذلك الخبر إما أن يحتمل تأويلا صحيحا أو لا يحتمله
فإن احتمله فإما أن يحتمل تأويلا قريبا أو تأويلا متعسفا
فإن كان قريبا جاز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قد تكلم به لإرادة ذلك المعنى كما في متشابهات الكتاب
وإن كان متعسفا حكم إما بكذبه وإما بأنه كان معه زيادة أو نقصان يصح الكلام معه مع أنه لم ينقل
وكذا القول فيما لا يقبل التأويل
الثالث
وهو في الحقيقة داخل تحت القسم الثاني الأمر الذي لو وجد لتوفرت الدواعي على نقله على سبيل التواتر إما لتعلق الدين به كأصول الشرع أو لغرابته كسقوط المؤذن من المنارة أو لهما جميعا كالمعجزات ومتى لم يوجد ذلك دل على كذبه
والخلاف فيه مع الشيعة فإنهم جوزوا في مثل هذا الشيء أن لا يظهر لأجل الخوف والتقية
لنا
لو جوزنا ذلك لجوزنا أن يكون بين البصرة وبين بغداد
بلدة أعظم منهما مع أن الناس ما أخبروا عنها
ولجوزنا أن يكون الرسول صلى الله عليه و سلم أوجب عشر صلوات لكن الأمة ما نقلت إلا خمسة ولما كان ذلك باطلا فكذا ما أدى إليه
فإن قيل هذا الكلام ظلم لأن العلم بعدم هذه الأمور إما أن يكون متوقفا على العلم بأنه لو كان لوجب نقله أو لا يكون متوقفا عليه
فإن كان الأول وجب أن يكون الشاك في الأصل شاكا في هذه الفروع لكن الناس كما يعلمون بالضرورة وجود بغداد والبصرة يعلمون بالضرورة عدم بلدة بينهما أكبر منهما والعلم الضروري لا يكون متوقفا على العلم النظري
وإن كان الثاني فحينئذ العلم بعدم هذه البلدة غير متوقف على العلم بأنها لو كانت لنقلت فلا يلزم من عدم هذا عدم ذاك
سلمنا توقف العلم بعدم هذه الأمور على العلم بأنها لو كانت لنقلت لكن ما ذكرتموه مثال واحد ولا يلزم من حصول الحكم في مثال واحد على وفق قولكم حصوله في كل الصور على وفق قولكم فإن قستم سائر الصور على هذه الصورة فقد بينا أن القياس لا يفيد اليقين لاحتمال أن يكون ما به
فارق الأصل الفرع شرطا في الأصل أو مانعا في الفرع
ثم الذي يبين أن الأمر ليس كذلك في كل الصور أمور
أحدها
أن إفراد الإقامة وتثنيتها من أظهر الأمور وأجلاها ثم إن ذلك لم ينقل بالتواتر
وثانيها
القول في هيئآت الصلاة من رفع اليدين والجهر بالتسمية كل ذلك أمور ظاهرة مع أنها لم تنقل نقلا متواترا
وثالثها
انشقاق القمر
وتسبيح الحصى وإشباع الخلق الكثير
من الطعام القليل ونبوع الماء من بين الأصابع أمور عظيمة
ثم إنها لم تنقل بالتواتر
فإن قلت ذلك لأنهم استغنوا بنقل القرآن عن نقلها
قلت لا نسلم حصول الاستغناء بنقل القرآن لأن كون القرآن معجزا أمر لا يعرف إلا بدقيق النظر والعلم بكون هذه الأشياء معجزات علم ضروري فكيف يقوم أحدهما مقام الآخر
فلأن قلتم لا نزاع في حصول التفاوت من هذه الجهة ولكن لما كان القرآن دليلا قاطعا جاز أن يصير ظهوره واشتهاره سببا لفتور الدواعي عن نقل سائر المعجزات وإن كانت أظهر من القرآن
فنقول لم لا يجوز أن يقال إن دلالة قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله ودلالة خبر
الغدير
والمنزلة على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإن كانت خفية إلا أن ذلك صار سببا لفتور الدواعي عن نقل النص الجلي
ورابعها
أن أقاصيص الأنبياء المتقدمين والملوك الماضين ما نقلت نقلا متواترا وهو يقدح في قولكم
والجواب
قوله العلم بعدم الواقعة العظيمة إما أن يتوقف على العلم بأنها لو كانت لنقلت أو لا يتوقف
قلنا يتوقف عليه
قوله العلم بعدم بلدة بين البصرة وبغداد أكبر منهما علم ضروري وهذه القاعدة نظرية والضروري لا يستفاد من النظري
قلنا لا نسلم أنه ضروري ولذلك فإن كل من ادعى نفي هذه البلدة إذا قيل له كيف عرفت عدمها فلا بد وأن يقول لأنها لو كانت موجودة لاشتهر خبرها كما اشتهر خبر بغداد والبصرة فعلمنا أن ذلك العدم مستفاد من هذا الأصل
قوله ما ذكرته مثال واحد
قلنا لم نذكر ذلك المثال لاختصاص دليلنا به بل للتنبيه على القاعدة الكلية
قوله ينتقض بالإقامة
قلنا اختلف أصحابنا في الجواب عنه على وجهين
الأول
وهو قول القاضي أبي بكر لعل المؤذن كان ينفرد مرة ويثنى أخرى
فإن قلت فكان يجب أن ينقل بالتواتر كونه كذلك
قلت يحتمل أن الراوي روى بعض ما رأى وأهمل الباقي لاعتقاده أن التساهل في مثل هذا الباب سهل ولا يتعلق به غرض أصلا في الدين نفيا وإثباتا
والثاني
لعلهم عرفوا أن هذه المسألة من الفروع التي لا يوجب الخطأ فيها كفرا ولا بدعة فلذلك تساهلوا فيها ولما تساهلوا فيها نسوا ما شاهدوه لا سيما وكانوا مشتغلين بالحروب العظيمة والذين
شاهدوها في زمان الرسول صلى الله عليه و سلم قتلوا وقلوا فصارت الرواية من باب الآحاد
وأما اختلافهم في الجهر بالتسمية فعنه أيضا جوابان الأول
لعل فعله فيه كان مختلفا
الثاني
أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا ابتدأ بالقراءة أخفى صوته ثم يعلو صوته على التدريج وعلى هذا التقدير يجوز أن يسمع جهره بالتسمية القريب دون البعيد وأما سائر المعجزات قلنا لعل الذين شاهدوا تلك الأشياء كانوا قليلين فلا جرم ما حصل النقل المتواتر
فأما الذين سمعوا النص الجلي في الإمامة فان كانوا قليلين صارت الرواية من الآحاد فلا تكون حجة قطعية
وإن كانوا بالغين حد التواتر وجب ظهور النقل
وأما أقاصيص سائر الأنبياء فإنما لم تنقل بالتواتر لأنه
لا يتعلق بروايتها غرض أصلي في الدين بخلاف النص الجلي في الإمامة
الرابع
الخبر الذي يروي في وقت قد استقرت فيه الأخبار فإذا فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة علم أنه لا أصل له
وأما في عصر الصحابة حين لم تكن قد استقرت الأخبار فإنه يجوز أن يروي أحدهم ما لم يوجد عند غيره
مسألة
في أن الأخبار المروية عن الرسول صلى الله عليه و سلم بالآحاد قد وقع فيها ما يكون كذبا
ثم في بيان الداعي إلى وضع الكذب عليه فهما مقامان أما المقام الأول فالذي يدل عليه وجوه
أحدها
ما روي عنه عليه الصلاة و السلام سيكذب علي
فهذا الخبر إن كان صدقا فلا بد من أن يكذب عليه وإن كان كذبا فقد كذب عليه أيضا
وثانيها
أنه قد حصل في الأخبار ما لا يجوز نسبته الى الرسول صلى الله عليه و سلم ولا يقبل التأويل وإذا كان كذلك وجب القطع بكونه كذبا
وثالثها
ما روي عن شعبة أن نصف الحديث كذب
وأما المقام الثاني وهو سبب الكذب فاعلم أن ذلك إما أن يكون من جهة السلف أو من جهة الخلف
أما السلف فهم منزهون عن تعمد الكذب إلا أنه لو وقع لوقع ذلك لوقع على وجوه
أحدها
أن يكون الراوي يرى نقل الخبر بالمعنى فيبدل مكان اللفظ اخر لا يطابقه في معناه وهو يرى أنه يقوم مقامه
وثانيها
أنهم لا يكتبون الحديث في الغالب فإذا قدم العهد فربما
نسي اللفظ فأبدل به لفظا اخر وهو يرى أن ذلك اللفظ هو المسموع وربما نسي زيادة يصح بها الخبر
وثالثها
ربما أدرك الرسول عليه الصلاة و السلام وهو يروي متن الخبر ولم يذكر إسناده إلى غيره فيظن أن الخبر من جهته صلى الله عليه و سلم ولهذا كان عليه الصلاة و السلام يستأنف الحديث إذا أحس بداخل ليكمل له
ومن ذلك ما وري أنه عليه الصلاة و السلام قال الشؤم في ثلاثة المرأة والدار والفرس فقالت عائشة رضي الله عنها إنما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك حكاية عن غيره
ورابعها
أنه ربما خرج الحديث على سبب وهو مقصور عليه ويصح معناه به وما هذا سبيله ينبغي أن يروى مع سببه فإذا لم يعرف سببه أوهم الخطأ كما روى أنه عليه الصلاة و السلام قال التاجر فاجر فقالت عائشة رضي الله عنها إنما قال ذلك في تاجر دلس
وخامسها
ما روي أن أبا هريرة كان يروي أخبار الرسول صلى الله عليه و سلم وكعب يروي أخبار اليهود والسامعون ربما ألبس عليهم ذلك فرووا في الخبر أنهم سمعوا من أبي هريرة وإنما سمعوا من كعب
وأما سبب الكذب في الأخبار من جهة الخلف فوجوه
أحدها
أن الملاحدة وضعوا الأباطيل ونسبوها إلى الرسول عليه الصلاة و السلام تنفيرا للعقلاء منه كما يروي ذلك عن عبد الكريم بن أبي العوجا
وثانيها
ما قيل إن الإمامية يسندون إلى الرسول صلى الله عليه و سلم كل ما صح عندهم عن بعض أئمتهم قالوا لأن جعفر بن محمد قال حدثني أبي وحدثني جدي وحديث أبي وجدي حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا حرج عليكم إذا سمعتم مني حديثا أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
وثالثها
أن يكون الراوي يرى جواز الكذب المؤدي إلى صلاح الأمة فإن من مذهب الكرامية أنه إذا صح المذهب جاز وضع الأخبار فيه لأن ذلك سبب لترويج الحق فوجب أن يكون جائزا
ورابعها
الرغبة كما وضعوا في ابتداء دولة بني العباس أخبارا في النص على إمامة العباس وولده
مسألة
في تعديل الصحابة رضي الله عنهم
مذهبنا إن الأصل فيهم العدالة إلا عند ظهور المعارض للكتاب والسنة
أما الكتاب فقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقوله تعالى لقد رضى الله عن المؤمنين وقوله تعالى والسابقون الأولون
و أما السنة فقوله عليه الصلاة و السلام أصحابي كالنجوم بأيهم أقتديتم اهتديتم وقوله ولا تسبوا أصحابي وقوله لو أنفق أحدكم ملأ الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقوله خير الناس قرني
وقد بلغ إبراهيم النظام في الطعن فيهم على ما نقله الجاحظ عنه في كتاب الفتيا ونحن نذكر ذلك مجملا ومفصلا
أما مجملا فإنه روي من طعن بعضهم في بعض أخبارا كثيرة يأتي تفصيلها وقال النظام رأينا بعض الصحابة يقدح في البعض وذلك يقتضي توجه القدح إما في القادح إن كان كاذبا وإما في المقدوح فيه إن كان القادح صادقا
بيان المقام الأول من وجوه
أقال عمران بن الحصين والله لو أردت لحدثت عن رسول الله عليه الصلاة و السلام يومين متتابعين فإني سمعت كما سمعوا وشاهدت كما شاهدوا ولكنهم يحدثون أحاديث ما هي كما يقولون وأخاف أن
يشبه لي كما شبه لهم
ب عن حذيفة أنه يحلف لعثمان بن عفان على أشياء بالله أنه ما قالها وقد سمعناه قالها فقلنا له فيه فقال إني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله
ج بن عباس رضي الله عنهما بلغه أن ابن عمر رضي الله عنهما يروي أن الميت ليعذب ببكاء أهله قال ذهل أبو عبد الرحمن إنما مر النبي عليه الصلاة و السلام بيهودي يبكي على ميت فقال إنه ليبكي عليه وإنه ليعذب
د ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة و السلام قال في الضب لا آكله ولا أحله ولا أحرمه فقال زيد الأصم قلت لابن عباس إن ناسا يقولون إنه عليه الصلاة و السلام قال في الضب لا آكله ولا أحله ولا أحرمه قال بئس ما قلتم ما بعث الله النبي محللا ولا محرما
ه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول فذكروه لعائشة رضي الله عنها فقالت لا بل قال إنهم ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق
قال النظام وهذا هو التكذيب
ولما روت فاطمة بنت قيس أن زوجي طلقني ثلاثا ولم يجعل لي رسول الله عليه الصلاة و السلام سكنى ولا نفقة فقال عمر لا نقبل قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت
وقالت عائشة رضي الله عنها يا فاطمة قد قتلت الناس ومعلوم أنها كانت من المهاجرات مع أنها عند عمر وعائشة رضي الله عنهما كاذبة
زأراد عمر رضي الله عنه ضرب أبي موسى رضي الله عنه في خبر الاستيذان حتى شهد له أبو سعيد الخدري
حكان علي رضي الله عنه يستحلف الرواة فلو كانوا غير متهمين لما استحلفهم فإن عليا أعلم بهم منا
طحميد بن عبد الرحمن الحميري بعث أبن أخ له إلى الكوفة وقال سل علي بن أبي طالب عن الحديث الذي رواه عنه أهل الكوفة في البصرة فإن كان حقا فخبرنا عنه فأتى الكوفة فلقى الحسن بن علي رضي الله عنهما فأخبره الخبر فقال له الحسن أرجع إلى عمك وقل له قال أمير المؤمنين يعني أباه إذا حدثتكم عن رسول الله فإني لن أكذب على الله ولا على رسوله
وإذا حدثتكم برأيي فإنما أنا رجل محارب
ويروي عنه هذا المعنى بروايات
قال عمرو بن عبيد الله وهاشم الأوقص يرى أن قوله
أمرت أن أقاتل الناس أو القاسطين أو المارقين من ذلك
وقوله في ذي الثدية ما كذبت ولا كذبت فإنما ربما كان الشيء عنده حقا فيقول إن الرسول أمرني به لأن الرسول كان آمرا بكل حق
يورويتم عن أبي سعيد الخدري وجابر وأنس رضي الله عنهم قال وذكر سنة مائة أنه لا يبقى على ظهرها نفس منفوسة
ثم يروي أن عليا رضي الله عنه قال لأبي مسعود إنك تفتي الناس قال أجل وأخبرهم أن الأخير شر قال فأخبرني ما سمعت منه قال سمعته يقول لا يأتي على الناس مائة سنة وعلى الأرض عين تطرف فقال علي أخطأت وأخطأ في أول فتواك إنما قال ذلك لمن حضره يومئذ وهل الرجاء الا بعد مائة
يا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة و السلام الشمس والقمر نوران مكوران في النار يوم القيامة قال الحسن ما ذنبهما قال أبو هريرة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
وهذا من الحسن رد على أبي هريرة
يب قال علي لعمر رضي الله عنهما في قصة الجنين إن كان هذا جهد رأيهم فقد قصروا وإن كانوا قاربوك فقد غشوك
وهذا من علي رضي الله عنه حكم بجواز اللبس
يج أبو الأشعث قال كنا في غزاة وعلينا معاوية رضي الله عنه فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا ببيعها للناس في أعطياتهم فتسارع الناس فيها فقام عبادة بن الصامت رضي الله عنه فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال يحدثون عن رسول الله عليه الصلاة و السلام أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه
فقام عبادة واعاد القصة ثم قال والله لنحدثن عن
رسول الله عليه الصلاة و السلام وإن كره معاوية
أو قال وأن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء
فهذا يدل إما على كذب عبادة أو كذب معاوية ولو كذبنا معاوية لكذبنا أصحاب صفين كالمغيرة وغيره
وعلى أن معاوية لو كان كذابا لما ولاه عمر وعثمان على الناس
يد إن أبا موسى قام على منبر الكوفة لما بلغه أن عليا رضي الله عنه أقبل يريد البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أهل الكوفة والله ما أعلم واليا أحرص على صلاح الرعية مني والله لقد منعتكم حقا كان لكم بيمين كاذبة فأستغفر الله منها
وهذا إقرار منه على نفسه باليمين الكاذبة
يه روى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يوم السقيفة أنه عليه الصلاة و السلام قال الأئمة من قريش ثم رويتم أشياء ثلاثة تناقضه
أحدها
قول عمر رضي الله عنه في آخر حياته لو كان سالم حيا لما تخالجني فيه شك وسالم مولى أمرأة من الأنصار وهي حازت ميراثه
وثانيها
أنه عليه الصلاة و السلام قال اسمع وأطع ولو كان عبدا حبشيا
وثالثها
قوله عليه الصلاة و السلام لو كنت مستخلفا من هذه الأمة أحدا من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد
يو لما روى أبو هريرة أنه عليه الصلاة و السلام قال إن المرأة والكلب والحمار يقطعن الصلاة مشت عائشة رضي الله عنها في خف واحدة وقالت لأخشن أبا هريرة فإني ربما رأيت الرسول عليه الصلاة و السلام وسط السرير وأنا على السرير بينه وبين القبلة
يز روي أبو هريرة أنه عليه الصلاة و السلام قال إن الميت على من غسله الغسل وعلى من حمله الوضوء فبلغ ذلك
عائشة رضي الله عنها فقالت أنجاس موتاكم
يح عن ابراهيم أن عليا رضي الله عنه بلغه أن أبا هريرة يبتدىء بميامينه في الوضوء وفي اللباس فدعا بماء فتوضأ وبدأ بمياسيره وقال لأخالفن أبا هريرة
يط إن أصحاب عبد الله لما بلغهم خبر أبي هريرة من قام من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا قالوا إن أبا هريرة مكثار فكيف نصنع بالمهراس
ك لما قال أبو هريرة حدثني خليلي قال له علي رضي الله عنه متى كان خليلك
وقال عمرو بن عبيد الله كأنه ما سمع قوله عليه الصلاة و السلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا
كا لما روي أبو هريرة من أصبح جنبا فلا صوم له أرسل مروان في ذلك إلى عائشة وحفصة رضي الله عنهما فقالتا كان النبي عليه الصلاة و السلام يصبح جنبا ثم يصوم فقال للرسول اذهب إلى أبي هريرة فأخبره بذلك
فقال أبو هريرة أخبرني بذلك الفضل بن عباس قال النظام والاستدلال به من ثلاثة أوجه
أحدها
أنه استشهد ميتا
وثانيها
أنه لو لم يكن متهما فيه لما سألوا غيره
وثالثها
أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما كذبتاه
كب ولما روى أبو سعيد الخدري خبر الربا قال ابن عباس نحن أعلم بهذا وفينا نزلت آية الربا فقال الخدري أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
وتقول لي ما تقول والله لا يظلني وإياك سقف بيت وهذا تكاذب بين ابن عباس وأبي سعيد
كج لما قدم ابن عباس البصرة سمع الناس يتحدثون عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم فكتب إليه فقال أبو موسى لا أعرف منها حديثا
كد روى أن عمر رضي الله عنه كان إذا ولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الأعمال وشيعهم قال لهم عند الوداع أقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال النظام فلولا التهمة لما جاز المنع من العلم
كه رووا عن سهل بن أبي خيثمة في القسامة ثم إن عبد الرحمن بن عبيد قال والله ما كان الحديث كما حدث سهل ولقد وهم وإنما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل خبير إن قتيلا وجد في أوديتكم فدوه فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه فواده رسول الله من عنده
وقال محمد بن اسحاق سمعت عمرو بن شعيب في المسجد الحرام يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن حديث سهل ليس كما حدث
كو قال أصحاب الشعبي إنك لا ترى طلاق المكره قال أنتم تكذبون علي وأنا حي فكيف لا تكذبون على إبراهيم وقد مات
كز قال ابن أبي ملكية ألا تعجب حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهللت بعمرة وقال القاسم إنها قالت بحجة
كح قال صدقة بن يسار سمعت أنه عليه الصلاة و السلام قال في الذي يسافر وحده وفي الإثنين شيطان وشيطانان فلقيت القاسم بن محمد فسألته فقال كان النبي صلى الله عليه و سلم يبعث البريد وحده وكان النبي وصاحبه وحدهما
فهذا من القاسم تكذيب بهذا الخبر
كط كان أبن سيرين يعيب الحسن في التفسير وكان الحسن يعيبه في التعبير ويقول كأنه من ولد يعقوب
ل ابن عباس رضي الله عنهما الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتي سودته خطايا أهل الشرك فسئل ابن الحنفية عن الحجر وقيل ابن عباس يقول هو من الجنة فقال هو من بعض الأودية
قال النظام لو كان كفر أهل الجاهلية يسود الحجر لكان إسلام المؤمنين يبيضه ولأن الحجارة قد تكون سوادء وبيضاء فلو كان ذلك السواد من الكفر لوجب أن يكون سوادها بخلاف سائر الأحجار ليحصل التمييز ولأنه لو كان كذلك لاشتهر ذلك لأنه من الوقائع العجيبة كالطير الأبابيل
لا روى أبو سعيد الخدري أنه لا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية فقال له مروان كذبت وعنده رافع
ابن خديج وزيد بن ثابت وهما قاعدان على سريره فقال أبو سعيد لو شاء هذان لعرفاك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة فسكتا فرفع مروان عليه الدرة فلما رأيا ذلك قالا صدق
لب عطاء بن أبي رباح قيل له روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال سبق الكتاب الخفين قال كذب
أنا رأيت ابن عباس يمسح على الخفين
لج قال أيوب لسعيد بن جبير إن جابر بن زيد يقول إذا زوج السيد العبد فالطلاق بيد السيد قال كذب جابر
لد قال عروة لابن عباس أضللت الناس يا ابن عباس قال وما ذاك يا عروة قال تأمرنا بالعمرة في هذه الأيام وليست فيها عمرة قال أفلا تسأل أمك عن هذا فإنها قد شهدته قال عروة فإن أبا بكر وعمر كانا لا يفعلانه قال هذا الذي أضلكم أحدثكم
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وتحدثونني عن أبي بكر وعمر فقال عروة أبو بكر وعمر كانا أتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وأعلم بها منك
وهذا تكذيب من عروة لابن عباس
له رويتم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال أي سماء تضلني ! وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأي
ثم رويتم أنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان
قال النظام وهذان الأثران متناقضان
ثم رويتم أن عمر رضي الله عنه قال إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر قال النظام فإن كان عمر استقبح مخالفة أبي بكر فلم خالفه في سائر المسائل فإنه قد خالفه في الجد وفي أهل الردة وقسمة الغنائم
ثم إن النظام قدح في ابن مسعود رضي الله عنه خاصة من وجوه
آ زعم أنه رأى القمر انشق وهذا كذب ظاهر لأن الله تعالى ما شق القمر له وحده وإنما يشقه آية للعالمين فكيف لم يعرف ذلك غيره ولم يؤرخ الناس به ولم يذكره شاعر ولم يسلم عنده كافر ولم يحتج به مسلم على ملحد
ب أنكر ابن مسعود كون المعوذتين من القرآن فكأنه ما شاهد قراءة الرسول صلى الله عليه و سلم لهما ولم يهتدء إلى ما فيهما من فصاحة المعجزة أو لم يصدق جماعة الأمة في كونهما من القرآن فإن كانت تلك الجماعة ليست حجة عليه فأولى أن لا تكون حجة علينا فنحن معذورون في أن لا نقبل قولهم
ج إختار المسلمون قراءة زيد وهو خالف الكل ولم يقرأ بها
د لما صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعا عابه فقيل له فيه فقال الخلاف شر والفرقة شر ثم إنه عمل بالفرقة في أمور كثيرة
ه وما زال يقدح القول في عثمان ويسر القول فيه منذ اختار قراءة زيد
و رأى أناسا من الزط فقال هؤلاء أشبه من رأيت بالجن ليلة الجن ثم قال علقمة قلت لابن مسعود أكنت مع النبي عليه الصلاة و السلام ليلة الجن فقال ما شهدها منا أحد
ز سأله عمر رضي الله عنه عن شيء من الصرف فقال لا بأس به فقال عمر رضي الله عنه لكني أكرهه فقال قد كرهته إذ كرهته فرجع عن قول إلى قول بغير دليل
قال النظام فقد ثبت قدح بعضهم في البعض فإن صدق القادح فقد توجه العيب وإن كذب فكذلك
أما الخوارج فقد طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم ولعن مبغضيهم من وجوه
أحدها
قالوا رأيناهم قبلوا خبر الواحد على مناقضة كتاب الله تعالى وذلك يوجب القطع بفساد ذلك الخبر والطعن في العامل به
بيانه
أن الله تعالى ذكر أنواع المعاصي من الكفر والقتل والسرقة فلما ذكر الزنا استقصى الكلام فيه فإنه تعالى نهى عنه فقال ولا تقربوا الزنا ثم أوعد عليه بالنار كما صنع وبجميع المعاصي ثم ذكر الجلد ثم خصه بإحضار المسلمين وبالنهي عن رحمته والرأفة عليه بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله
ثم جعل على من رمى مسلما بالزنا ثمانين جلدة ولم يجعل ذلك على من رماه بالقتل ولا بالكفر وهما أعظم
ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
ثم ذكر من رمى به زوجته وبين هناك أحكام اللعان وقال والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك
ثم خصه بأن جعل الشهود عليه أربعا فمع هذه المبالغة العظيمة كيف يجوز إهمال ما هو أجل أحكامها وأعظم مراتبها وهو الرجم
ثم إنه تعالى ذكر آيات صريخة في نفي الرجم
أحدها
قوله الزانية والزاني فاجلدوا وهذا صريح في وجوب الجلد على كل الزناة
وصريح في نفي الرجم
وثانيها
قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم لا نصف له
وثالثها
وهو الدلالة العقيلة أن الرجم لو كان مشروعا لوجب أن ينقل نقلا متواترا لأنه من الوقائع العظيمة فحيث لم ينقل دل على أنه غير مشروع
ثم أنهم قبلوا خبر الواحد في الرجم مع كونه على مناقضة هذه الأدلة الشرعية والعقلية فكان الطعن متوجها قطعا
وثانيها
رويتم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه خرج يوما على أصحابه وهم يكتبون أحاديث من أحاديثه فقال ما هذه الكتب أكتابا مع كتاب الله تعالى يوشك أن يقبض الله تعالى بكتابه فلا يدع في قلب ولا رق منه شيئا إلا أذهبه
ورويتم أيضا أنه قال إذا حدثتم بحديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه ثم إنكم مع ذلك جوزتم المسح على الخفين مع صريح قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة
وقلتم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويحرم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وبنت أخيها وأختها مع قوله تعالى وأحل لكم ما وراءه ذلكم
وكيف يجلد العبد القاذف أربعين مع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ولم يذكر حرا ولا عبدا
وكيف يجلد العبد على الزنا خمسين وإنما ذكر الله تعالى الإماء دون العبيد فقال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
وكيف رددتم شهادة العبد مع قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ومع قوله ممن ترضون من الشهداء
وكيف منعتم من إمامة غير القرشي مع قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم
وثالثها
ما يروى من شتم بعضهم بعضا ولنذكر من ذلك حكايات الحكاية الأولى حكى ابن داب في مجادلات قريش
قال اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص وعتبة بن أبي سفيان والوليد بن عقبة والمغيرة بن شعبة ثم أحضروا الحسن بن علي رضي الله عنهم ليسبوه
فلما حضر تكلم عمرو بن العاصى وذكر عليا رضى الله عنه ولم يترك شيء من المساويء الا ذكر فيه
وفيما قال إن عليا شتم أبا بكر وشارك في دم عثمان إلى أن قال اعلم أنك وأباك من شر قريش
ثم خطب كل واحد منهم بمساوىء علي والحسن رضي الله
عنهما ومقابحهما ونسبوا عليا إلى قتل عثمان ونسبوا الحسن إلى الجهل والحمق
فلما ال الأمر إلى الحسن رضي الله عنه خطب ثم بدأ يشتم معاوية رضي الله عنه وطول فيه إلى قال له إنك كنت ذات يوم تسوق بأبيك ويقود به أخوك هذا القاعد وذلك بعدما عمي أبو سفيان فلعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمل وراكبه وسائقه وقائده فكان أبوك الراكب وأخوك القائد وأنت السائق
ثم قال لعمرو بن العاص إنما أنت سبة كما أنت فأمك زانية اختصم فيك خمسة نفر من قريش كلهم يدعي عليك أنك أبنه فغلب عليك جزار قريش من الأمهم حسبا وأقلهم منصبا وأعظمهم لعنة ما أنت إلا شانىء محمد فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه و سلم إن شانئك هو الأبتر
ثم هجوت رسول الله صلى الله عليه و سلم تسعين قافية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم إني لا أحسن الشعر فالعنه بكل قافية لعنة
وأما أنت يا ابن أبي معيط فوالله ما ألومك أن تبغض عليا وقد جلدك في الخمر وفي الزنا وقتل أباك صبرا بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم بدر وسماه الله تعالى في عشر آيات مؤمنا وسماك فاسقا وأنت فاسقا وأنت علج من أهل النورية
أما أنت يا عتبة فما أنت بحصيف فأجيبك ولا عاقل فأعاتبك وأما وعدك إياي بالقتل فهلا قتلت الذي وجدت في فراشك مع أهلك
وأما أنت يا مغيرة بن شعبة فمثلك مثل البعوضة إذ قالت للنخلة استمسكي فإني عليك نازلة فقالت النخلة والله ما شعرت بوقوعك علي
وأما زعمك أنه قتل عثمان فلعمري لو قتل عثمان ما كنت منه في شيء وإنك لكاذب
قال الخوارج فهذه المشاتمة العظيمة المتناهية التي دارت بينهم تدل على أنهم ما كانوا يمسكون ألسنتهم عن القذف والقدح في الدين والعرض وذلك بوجب القدح العظيم في احدى الطائفتين
الحكاية الثانية
أن عثمان رضي الله عنه أخر عن عائشة رضي الله عنها بعض أرزاقها فغضبت ثم قالت يا عثمان أكلت أمانتك وضيعت الرعية وسلطت عليهم الأشرار من أهل بيتك والله لولا الصلوات الخمس لمشى إليك أقوام ذوو بصائر يذبحونك كما يذبح الجمل
فقال عثمان رضي الله عنه ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الآية فكانت عائشة رضي الله عنها تحرض عليه جهدها وطاقتها وتقول أيها الناس هذا قميص رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يبل وقد بليت سنته اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا
ثم إن عائشة ذهبت إلى مكة فلما قضت حجها وقربت من المدينة أخبرت بقتل عثمان فقالت ثم ماذا فقالوا بايع الناس علي بن أبي طالب فقالت عائشة قتل عثمان والله مظلوما وأنا طالبة بدمه والله ليوم من عثمان خير من علي الدهر كله
فقال لها عبيد بن أم كلاب ولم تقولين ذلك فوالله ما أظن أن بين السماء والأرض أحدا في هذا اليوم أكرم على الله من علي بن أبي طالب فلم تكرهين ولايته ألم تكوني تحرضين الناس على قتله فقلت اقتلوا النعثل فقد كفر فقالت عائشة لقد قلت ذلك ثم رجعت عما قلت وذلك أنكم أسلمتموه حتى إذا جعلتموه في القبضة قتلتموه والله لأطلبن بدمه
فقال عبيد بن أم كلاب هذا والله تخليط يا أم المؤمنين
الحكاية الثالثة
الخصومة العظيمة التي كانت بين عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمار وبين عثمان
والخصومة التي كانت بين عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم حتى آل الأمر إلى الضرب والنفي عن البلد واللعن وكل ذلك يقتضي توجه القدح إلى عدالة بعضهم
الحكاية الرابعة
مقتل عثمان رضي الله عنه والجمل وصفين
ثم قالت الخوارج رأينا هؤلاء المحدثين يجرحون الراوي بأدنى سبب ثم إنهم مع علمهم بهذه القوادح العظيمة يقبلون روايات الصحابة ويعملون بروايات القادح والمقدوح فيه وهذا ليس من الدين في شيء بل هؤلاء المحدثون أتباع كل من عز وعبيد كل
من غلب ويروون لأهل كل دولة في ملكهم فإن انقضت دولتهم تركوهم
ومما رواه الكل أن إماما سيكون منهم وأنه سيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا فروت الحسينية ذلك لنفسها وروت العباسية لنفسها حتى سموا ولد المنصور مهديا وحتى روت الأموية مثل ذلك في السفياني وسموا سليمان بن عبد الملك مهديا وحتى روت اليمانية في الأصغر
القحطاني إلى أن خرج ابن الأشعث على ذلك الطمع تارة ويزيد بن الملهب أخرى
ورابعها
قالوا إنا نعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه و سلم
متى كان يشرع في الكلام فالصحابة ما كانوا يكتبون كلامه من أوله إلى آخره لفظا وإنما كانوا يسمعونه ثم يخرجون من عنده وربما رووا ذلك الكلام بعد ثلاثين سنة
ومن المعلوم أن العلماء الذين تعودوا تلقف الكلام ومارسوه وتمرنوا عليه لو سمعوا كلاما قليلا مرة واحدة فأرادوا إعادته في تلك الساعة بتلك الألفاظ من غير تقديم ولا تأخير لعجزوا عنه فكيف الكلام الطويل بعد المدة المتطاولة من غير تكرار ولا كتابة
ومن أنصف قطع بأن هذه الأخبار التي رووها ليس شيء من ألفاظها لفظ الرسول صلى الله عليه و سلم ثم من يعيد الكلام بعد هذه ال مدة لا يمكنه أن يعيد معناه بتمامه فإن الإنسان مظنة النسيان بل لا يعيد الا بعضه
وإذا كان كذلك لزم القطع بسقوط الحجة عن هذه الألفاظ لا سيما وقد جربناهم فرأيناهم يذكرون الكلام الواحد في الواقعة الواحدة بروايات كثيرة مع زيادات ونقصانات
وأحسن الأحوال في ذلك أن نحمل ما قلناه من عدم حفظ الألفاظ وتغيير التقديم والتأخير بسبب طول المدة وكل ذلك يوجب القدح في هذه الأخبار
والجواب
اعلم أن اعتماد أصحابنا في هذا الباب على حجة واحدة وهي أن آيات القرآن دالة على سلامة أحوال الصحابة
وبراءتهم من المطاعن
وإذا كان كذلك وجب علينا أن نحسن الظن بهم إلى أن يقوم دليل قاطع على الطعن فيهم
وأما هذه المطاعن التي ذكرتموها فمروية بالآحاد فإن فسدت رواية الآحاد فسدت هذه المطاعن
وإن صحت فسدت هذه المطاعن أيضا فعلى كل التقديرات هذه المطاعن مدفوعة فيبقى الأصل الذي ذكرناه سليما
وأما طعن الخوارج فهو بناء على أن تخصيص الكتاب بخبر الواحد لا يجوز وقد تقدم القول فيه
و أما قولهم أن الظاهر أن هذه الألفاظ ليست ألفاظ الرسول عليه الصلاة و السلام
قلت لما ثبت الظاهر من حال الراوي العدالة وقد أخبر بأنها ألفاظ الرسول صلى الله عليه و سلم وجب تصديقه فيه
ظاهرا والله أعلم
القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا وفيه أبواب
الباب الأول في إقامة الدليل على أنه حجة في الشرع
اختلف الناس فيه فالأكثرون جوزوا التعبد به عقلاوالأقلون منعوا منه عقلا
أما المجوزون فمنهم من قال وقع التعبد به
ومنهم من قال لم يقع التعبد به
والذين قالوا وقع التعبد به اتفقوا عى أن الدليل السمعي دل عليه
واختلفوا في ان الدليل العقلي هل دل عليه
فذهب القفال وابن سريج منا وأبو الحسين البصري من المعتزلة إلى أن دليل العقل دل على وقوع التعبد به
أما الجمهور منا ومن المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار فقد اتفقوا على أن دليل التعبد به السمع فقط
وهو قول أبي جعفر الطوسي من الإمامية
أما الذين قالوا لم يرد التعبد به فهم فرق ثلاث الأولى أنه لم يوجد ما يدل على كونه حجة فوجب القطع بأنه ليس بحجة
والثانية أنه جاء في الأدلة السمعية ما يدل على أنه ليس بحجة
والثالثة أن الدليل العقلي قائم على امتناع العمل به
ثم إن الخصوم بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا تعلم صحته كما في الفتوى وفي الشهادة وفي الأمور الدنيوية
لنا
النص والإجماع والسنة المتواترة والقياس والمعقول
أما النص فوجهان
الأول
قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وجه الاستدلال أن الله تعالى أوجب الحذر بإخبار الطائفة والطائفة ها هنا عدد لا يفيد قولهم العلم ومتى وجب الحذر باخبار عدد لا يفيد قولهم العلم فقد وجب العمل بالخبر الذي لا نقطع بصحته
وإنما قلنا أنه أوجب الحذر عند إخبار الطائفة لأنه أوجب الحذر بإنذار الطائفة والإنذار هو الإخبار
وانما قلنا أنه اوجب الحذر بإنذار الطائفة لقوله تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وكلمه لعل للترجي وذلك في حق الله تعالى محال
وإذا تعذر حمله على ظاهره وجب حمله على المجاز وذلك لأن المترجي طالب للشيء فإذا كان الطلب لازما للترجي وجب
حمل هذا اللفظ على الطلب فيلزم أن يكون الله طالبا للحذر وطلب الله تعالى هو الأمر فثبت أن الله تعالى أمر بالحذر عند انذار الطائفة
وإنما قلنا إن الإنذار هو الإخبار لأنه عبارة عن الخبر المخوف والخبر داخل في الخبر المخوف فثبت أن الله تعالى أوجب الحذر عند إخبار الطائفة
وإنما قلنا إن الطائفة ها هنا عدد لا يفيد قولهم العلم لأن كل ثلاثة فرقة والله تعالى أوجب على كل فرقة أن تخرج منها طائفة والطائفة من الثلاثة واحد أو اثنان وقول الواحد أو الإثنين لا يفيد العلم
وإنما قلنا إنه تعالى لما أوجب الحذر عند خبر العدد الذي لا يفيد قولهم العلم وجب العمل بذلك الخبر لأن قوما إذا فعلوا فعلا وروي الراوي لهم خبرا يقتضي المنع من ذلك الفعل فإما أن يجب عليهم تركه عند سماع ذلك الخبر أو لا يجب
فإن وجب فهو المراد من وجوب العمل بمقتضى ذلك الخبر وإذا ثبت وجوب العمل بمقتضى ذلك الخبر في هذه الصورة وجب العمل به في سائر الصور ضرورة أن لا قائل بالفرق
وإن لم يجب الترك لم يجب الحذر وذلك ينافي ما دلت الآية عليه من وجوب الحذر
فإن قيل لا نسلم أنه تعالى أوجب الحذر عند إنذار الطائفة وأما قوله تعالى لعلهم يحذرون قلنا سلمتم أنه لا يمكن حمله على ظاهره فلم قلتم إنه يجب حمله على ذلك المجاز ولم لا يجوز حمله على مجاز اخر لا بد فيه من الدليل
سلمنا وجوب الحذر عند الإنذار لكن لا نسلم إن الإنذار هو الإخبار فإن الإنذار من جنس التخويف فنحن نحمل الآية على التخويف الحاصل من الفتوى بل هذا أولى لأنه أوجب التفقه لأجل الإنذار والتفقه إنما يحتاج إليه في الفتوى لا في الرواية
فإن قلت الحمل على الفتوى متعذر لوجهين
الأول
أنا لو حملناه على الفتوى لاختص لفظ القوم بغير المجتهدين لأن المجتهد لا يجوز له العمل بفتوى المجتهد لكن التقييد غير جائز لأن الآية مطلقة في وجوب إنذار القوم سواء كانوا مجتهدين أو لم يكونوا كذلك أما لو حلمناه على رواية الخبر لا يلزمنا ذلك لأن الخبر كما يروي لغير المجتهد فقد يروي أيضا للمجتهد و الثاني
أن من شرب النبيذ فروى إنسان خبرا يدل على أن شاربة في النار فقد أخبره بخبر مخوف ولا معنى للإنذار إلا ذلك فصح وقوع اسم الإنذار على الرواية
ثم بعد ذلك نقول لا يخلو إما أن لا يقع اسم الإنذار على الفتوى أو يقع
فإن لم يقع فقد حصل الغرض من أن المراد من الانذار الرواية لا الفتوي
وإن وقع لم يجز جعله حقيقة فيهما دفعا للاشتراك فوجب
جعله حقيقة في القدر المشترك وهو الخبر المخوف
وعلى هذا التقدير يكون متناولا للرواية والفتوى جميعا وذلك مما لا يضرنا
قلت الجواب عن الأول
أنه كما يلزم من حمل الإنذار على الفتوى تخصيص لفظ القوم بغير المجتهد يلزم من حمله على الرواية تخصيص لفظ القوم بالمجتهد لإجماعنا على أنه لا يجوز للعامي أن يستدل بالحديث فالتقييد لازم عليكم كما أنه لازم علينا فعليكم الترجيح
ثم أنه معنا لأن غير المجتهد أكثر من المجتهد والتقييد كلما كان أقل كان أولى
وعن الثاني
أنه إذا كان المراد من الإنذار القدر المشترك بين الفتوى والرواية والمأمور به إذا كان مشتركا فيه بين صور كثيرة كفى في الوفاء بمقتضى الأمر الاتيان بصورة واحدة من تلك الصور لأنه إذا كان المطلوب إدخال القدر المشترك بين الفتوى والرواية في الوجود وذلك المشترك يحصل في الفتوى فالقول بكون الفتوى حجة
يكفي في العمل بمقتضى النص فلا تبقى للنص دلالة على وجوب العمل بالرواية
سلمنا أن المراد من الإنذار رواية الخبر فقط لكن لم لا يجوز أن يكون المراد رواية أخبار الأولين وكيفية ما فعل الله تعالى بهم لأن سماع أخبارهم يقتضي الاعتبار على ما قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب
أو يكون المراد منه التنبيه على وجوب النظر والاستدلال
سلمنا أن الآية تقتضي وجوب الحذر عند خبر الطائفة فلم قلت إن الطائفة اسم لعدد لا يفيد قولهم العلم
قوله لأن كل ثلاثة فرقة والخارج من الثلاثة واحد أو أثنان
قلنا لا نسلم أن كل ثلاثة فرقة فما الدليل
ثم إن الذي يدل على بطلانه وجهان
الأول
أنه يقال الشافعية فرقة واحدة لا فرق ولو كان كل ثلاثة فرقة لما كان الشافعية واحدة بل فرقا
الثاني
أنه تعالى أوجب على كل فرقة أن تخرج منها طائفة للتفقه ولو كان كل ثلاثة فرقة لوجب أن يخرج من كل ثلاثة واحد وذلك باطل بالاتفاق
سلمنا أن الطائفة اسم لعدد لا يفيد قولهم العلم فلم قلت إنه يقتضي وجوب الحذر بقول عدد لا يفيد قولهم العلم
بيانه
أن الطائفة عندكم اسم للواحد أو الإثنين وقوله ولينذوا قومهم ضمير جمع وأقل الجمع ثلاثة على ما تقدم
فإذن قوله ولينذروا ليس عائدا إلى كل واحد من تلك الطوائف بل إلى مجموعها
فلم قلت إن مجموع تلك الطوائف ما بلغوا حد التواتر
سلمنا أن الآية تقتضي وجوب الحذر عند خبر من لا يفيد قولهم العلم فلم قلت إنها تقتضي وجوب العمل بذلك الخبر فإنا إنما نوجب عليهم ذلك الترك للاحتياط حتى إنه لو كان عاميا وجب عليه الرجوع إلى المفتي فإن أذن له جاز له العود اليه
وإن كان مجتهدا نظر في سائر الأدلة فإن وجد فيها ما يقتضي المنع من ذلك الفعل امتنع منه وإلا جاز له العود إليه
والجواب
قوله لم قلت إنه يفيد وجوب الحذر
قلنا لثلاثة أوجه
الأول
أنه لا يجوز حمله على ظاهره فوجب حمله على الأمر به قوله لم قلت ليس ها هنا مجاز اخر
قلت لأن الأصل عدم المجاز فإذا وجد هذا المجاز الواحد فالظاهر عدم سائر المجازات
الثاني
أن قوله تعالى لعلهم يحذرون يقتضي إمكان تحقق الحذر في حقهم والحذر هو التوقي من المضرة والفعل الذي يقتضي خبر الواحد المنع منه قد لا يكون مضرا في الدنيا فلا بد وأن يكون مضرا في الآخرة وإلا لم يكن الحذر ممكنا ولا معنى لمضره الآخرة إلا العقاب فإذا كان هو بحال يحذر عنه وجب أن يكون بحال يترتب العقاب على فعله ولا معنى لقولنا خبر الواحد حجة إلا هذا القدر
الثالث
أن قوله تعالى لعلهم يحذرون إن لم يقتض وجوب الحذر فلا أقل من أن يقتضي حسن الحذر وذلك
يقتضي جواز العمل بخبر الواحد والخصم ينكره فصار محجوجا به
قوله لم لا يجوز أن يكون المراد الفتوى
قلنا للوجهين المذكورين
أحدهما
أنا لو حملناه على الفتوى لزم تخصيص القوم بغير المجتهد قوله ولو حملناه على الرواية لزم تخصيصه بالمجتهد قلنا لا نسلم فإن الخبر كما يروى للمجتهد فقد يروى لغير المجتهد بلى لا يجوز لغير المجتهد أن يتمسك به ولكن ينتفع به من وجوه أخر
منها أنه ينزجر عن فعله ويصير ذلك داعيا له إلى الرجوع إلى المفتي وربما بحث عنه واطلع على معناه
الوجه الثاني
انا نحمله على القدر المشترك قوله يكفي في العمل به ثبوته في صورة واحدة
قلنا الجواب عنه من وجهين الأول أنه رتب وجوب الحذر على مسمى الإنذار الذي هو القدر المشترك
فوجب كون هذا القدر المشترك علة للحكم فوجب أن يكون الحكم ثابتا أينما ثبت هذا المسمى
والثاني
أن قبل ورود هذه الآية إما أن يقال كان الأمر بقبول الفتوى واردا أو ما كان واردا
فإن كان واردا لم يجز حمل هذه الآية عليه وإلا كان ذلك تكريرا من غير فائدة
وإن قلنا إنه ما كان واردا وجب حمله على الأمر بالصورتين وإلا تطرق الإجمال إلى الآية وهو خلاف الأصل
قوله لم لا يجوز أن يكون المراد من الإنذار رواية أخبار الأولين
قلنا الجواب عنه كما تقدم على السؤال الأول قوله لم قلت كل ثلاثة فرقة
قلنا لأن الفرقة في أصل اللغة فعلة من فرق أو
فرق كالقطعة من قطع أو قطع وكل شيء حصل الفرق أو التفريق فيه كان فرقة كما أن كل ما حصل القطع أو التقطيع فيه كان قطعة ولذلك من شق الخشبة يقال فرقها فرقا
وإذا كان كذلك فالفرقة في اللغة تقع على كل واحد من الأشخاص حقيقة إلا أنا خصصناها في هذه الآية بالثلاثة حتى يمكن خروج الطائفة عنها فوجب أن تبقى حقيقة في الثلاثة
قوله أصحاب الشافعي رضي الله عنه فرقة واحدة
قلنا ذلك لأنهم بحسب المذهب امتازوا عن غيرهم فلأجل هذا الافتراق سموا فرقة واحدة أما بحسب الشخص فهم فرق
قوله إن الله تعالى أوجب على كل فرقة أن تخرج منها
طائفة للتفقه ولا يجب ذلك على كل ثلاثة
قلنا ترك العمل به في حق هذا الحكم فيبقى معمولا به في الباقي
قوله لم لا يجوز أن يكون المراد أن ينذر مجموع الطوائف قومهم
قلنا هذا باطل لقوله إذا رجعوا إليهم لأنه لا يجوز أن يقال فلان رجع إلى ذلك الموضع إلا بعد أن كان فيه ومعلوم أن الطائفة من كل فرقة ما كانت في غير تلك الفرقة ولا يمكن أن يقال كل طائفة ترجع إلى كل الفرق بل إنما يمكن رجوعها إلى فرقتها الخاصة
قوله الضمير في قوله ولينذروا ليس ضمير الواحد والإثنين
قلنا هذا لا يضرنا لأنه تعالى قابل مجموع الطوائف بمجموع القوم فيتوزع البعض على البعض
قوله لم قلت إنه يدل على وجوب الترك بذلك الخبر
قلنا لما تقدم
قوله يجب عليه الترك في الحال ليستفتى إن كان عاميا وليتأمل إن كان مجتهدا
قلنا هذا باطل لأن العامي لا يجوز له الإقدام على الفعل إلا بعد أن يعلم أولا جواز ذلك الفعل من جهة المفتي ومتى علم الفتوى لم يجب عليه الاستفتاء مرة أخرى
وأما المجتهد فإن كان خبر الواحد حجة عليه فهو المطلوب وإن لم يكن دليلا لم يجب عليه التوقف لانعقاد الإجماع على أن الذي لا يكون دليلا لا يمنعه عن فعل ما ثبت له جواز فعله بدليل متقدم
المسلك الثاني
لو وجب في خبر الواحد أن لا يقبل لما كان كون خبر الفاسق غير مقبول معللا بكونه فاسقا لكنه معلل به فلم يجب في خبر
الواحد أن لا يقبل فإذا لم يجب أن لا يقبل جاز قبوله في الجملة وهو المقصود
بيان الملازمة أن كون الراوي الواحد واحدا أمر لازم لشخصه المعين يمنع خلوه عنه عقلا
وأما كونه فاسقا فهو وصف عرضي يطرى ويزول واذا اجتمع في المحل وصفان أحدهما لازم والآخر عرضي مفارق وكان كل واحد منهما مستقلا باقتضاء الحكم كان الحكم لا محالة مضافا إلى اللازم لأنه كان حاصلا قبل حصول المفارق وموجبا لذلك الحكم وحين جاء المفارق كان ذلك الحكم حاصلا بسبب ذلك اللازم وتحصيل الحاصل مرة
أخرى محال فيستحيل إسناد ذلك الحكم إلى ذلك المفارق
مثاله يستحيل أن يقال الميت لا يكتب لعدم الدواة والقلم عنده لأن الموت لما كان وصفا لازما مستقلا بامتناع صدور الكتابة عنه لم يجز تعليل امتناع الكتابة بالوصف العرضي وهو عدم الدواة والقلم
وإنما قلنا إنه معلل به لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أمر بالتثبت مرتبا على كونه فاسقا والحكم المرتب على الوصف المشتق المناسب يقتضي كونه معللا بما منه الاشتقاق ولا شك في أن الفسق يناسب عدم القبول فثبت بما ذكرنا أن خبر الواحد لو وجب أن لا يقبل لامتنع تعليل أن لا يقبل خبر الفاسق بكونه فاسقا وثبت أنه معلل به فخبر الواحد لا يجب أن لا يقبل فهو إذن مقبول في الجملة
ومن الناس من تمسك بالآية على وجه آخر وهو أنه تعالى
أمر بالتثبت بشرط أن يكون الخبر صادرا عن الفاسق والمشروط بالشيء عدم عند عدم الشرط فوجب أن لا يجب التثبت إذا لم يوجد مجيء الفاسق فإذا جاء غير الفاسق ولم يتثبت فإما أن يجزم بالرد وهو باطل وإلا كان خبر العدل أسوأ حالا من خبر الفاسق وهو باطل بالإجماع فيجب القبول وهو المطلوب
المسلك الثالث
السنة المتواترة وهو ما روي أنه صلى الله عليه و سلم كان يبعث رسله إلى القبائل لتعليم الأحكام مع أن كل واحد من أولئك الرسل ما كانوا بالغين حد التواتر
واعترض أبو الحسين البصري على هذه الدلالة بسؤال واقع فقال كان يبعثهم إلى القبائل للفتوى أو لرواية الخبر
الأول مسلم والثاني ممنوع
بيانه
أن العوام في القبائل كانوا أكثر من المجتهدين فكانت حاجتهم إلى الفتوى أشد من حاجتهم إلى من يروى لهم الخبر ليحتجوا به
وبالجملة هب أن هذا الاحتمال ليس أظهر لكن لا بد من قيام الدلالة على قطع هذا الإحتمال ليتم الاستدلال
المسلك الرابع الإجماع
العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع عليه بين الصحابة فيكون العمل به حقا
إنما قلنا إنه مجمع عليه بين الصحابة لأن بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لا يقطع بصحته ولم ينقل عن أحد منهم إنكار على فاعله وذلك يقتضي حصول الإجماع
وإنما قلنا إن بعض الصحابة عمل به لوجهين
الأول
وهو أنه روى بالتواتر أن يوم السقيفة لما احتج أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار بقوله عليه الصلاة و السلام الأئمة من قريش مع أنه مخصص لعموم قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم
قبلوه ولم ينكر عليه أحد ولم يقل له أحد كيف تحتج علينا بخبر لا نقطع بصحته فلما لم يقل أحد منهم ذلك علمنا أن ذلك كان كالأصل المقرر عندهم
الثاني
الاستدلال بأمور لا ندعي التواتر في كل واحد منها بل في مجموعها وتقريره أن نبين أن الصحابة عملوا على وفق خبر الواحد ثم نبين أنهم إنما عملوا به لا بغيره
أما المقام الأول فبيانه من وجوه
الأول
رجوع الصحابة إلى خبر الصديق في قوله عليه الصلاة و السلام الأنبياء يدفنون حيث يموتون وفي قوله
الأئمة من قريش وفي قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث
وإلى كتابه في معرفة نصب الزكوات ومقاديرها
الثاني روي أن أبا بكر رضي الله عنه رجع في توريث الجدة إلى خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة
ونقل عنه أيضا أنه قضى بقضية بين أثنين فأخبره بلال أنه عليه الصلاة و السلام قضى فيها بخلاف قضاءه فرجع اليه
الثالث
روي أن عمر رضي الله عنه كان يجعل في الأصابع نصف الدية ويفصل بينها فيجعل في الخنصر ستة وفي البصر تسعة وفي الوسطى والسبابة عشرة عشرة وفي الأبهام خمسة عشر فلما روي له في كتاب عمرو بن حزم أن في كل أصبع عشرة رجع عن رأيه
الرابع
وقال في الجنين رحم اله امرأ سمع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين شيئا فقام إليه حمل بن مالك فأخبره بأن الرسول عليه الصلاة و السلام قضى فيه بغرة فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره
الخامس
أنه كان لا يرى ثوريث المرأة من دية زوجها فأخبره الضحاك أنه عليه الصلاة و السلام كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع إليه
السادس
تظاهرت الرواية أن عمر قال في المجوس ما أدري ما أصنع بهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول سنوا بهم سنة أهل
الكتاب فأخذ منهم الجزية وأقرهم على دينهم
السابع
أنه ترك العمل برأيه في بلاد الطاعون بخبر عبد الرحمن
الثامن
روي عن عثمان أنه رجع إلى قول فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري حين قالت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أستأذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة
فقال صلى الله عليه و سلم امكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك
ولم ينكر عليها الخروج للاستفتاء فأخذ عثمان بروايتها في الحال و في أن المتوفي عنها زوجها تعتد في منزل الزوج ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا إن لم يكن لها من يقوم بأحوالها
التاسع
اشتهر عن علي رضي الله عنه أنه كان يحلف الراوي وقبل رواية أبي بكر رضي الله عنه من غير حلف
وأيضا قبل رواية المقداد بن الأسود في حكم المذي
العاشر
رجوع الجماهير إلى قوم عائشة رضي الله عنها في وجوب الغسل من التقاء الختانين
الحادي عشر
رجوع الصحابة في الربا إلى خبر أبي سعيد
الثاني عشر
قال ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى به بأسا حتى روى لنا رافع بن خديج نهيه عليه الصلاة و السلام عن المخابرة
الثالث عشر
قال أنس كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب إذا أتانا آت فقال حرمت الخمر فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت فكسرتها
الرابع عشر
اشتهر عمل أهل قباء في التحول عن القبلة بخبر الواحد
الخامس عشر
قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن فلان يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني اسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو الله أخبرني أبي بن كعب قال خطب بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وذكر موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني اسرائيل
السادس عشر
عن أبي الدرداء أنه لما باع معاوية شيئا من أواني
الذهب والفضة بأكثر من وزنها قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عنه فقال معاوية لا أرى به بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن الرسول عليه الصلاة و السلام وهو يخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أبدا
فهذه الأخبار قطرة من بحر هذا الباب ومن طالع كتب الأخبار وجد فيها من هذا الجنس ما لا حد له ولا حصر وكل واحد منها وإن لم يكن متواترا لكن القدر المشترك فيه بين الكل وهو العمل على وفق الخبر الذي لا تعلم صحته معلوم فصار ذلك
متواترا في المعنى
و أما المقام الثاني
وهو أنهم انما عملوا على وفق هذه الأخبار لأجلها فبيانه من وجهين
الأول
لو لم يعلموا لأجلها بل لأمر آخر إما لاجتهاد تجدد لهم أو ذكروا شيئا سمعوه من الرسول عليه الصلاة و السلام لوجب من جهة العادة والدين أن يظهروا ذلك
أما العادة فلأن الجمع العظيم إذا اشتد اهتمامهم بأمر قد التبس ثم زال اللبس عنهم فيه لدليل سمعوه أو لرأي حدث فيه فإنه لا بد لهم من إظهار ذلك الدليل والاستبشار بسبب الظفر به والتعجب من ذهاب ذلك عليهم فإن جاز في الواحد أن لا يظهر له ذلك لم يجز في الكل
أما الدين فلأن سكوتهم عن ذكر ذلك الدليل وعملهم
عند الخبر بموجبه يوهم أنهم عملوا لأجله كما يدل عملهم بموجب اية سمعوها على أنهم عملوا لأجلها وايهام الباطل غير جائز
كما أنه لو قال لهم قائل احكموا في هذه المسألة بمجرد شهوتي فتذكروا عند ذلك خبرا سمعوه من الرسول صلى الله عليه و سلم فإنه لا يحسن من جهة الدين أن لا يبينوا أنهم إنما حكموا لذلك الدليل لا لشهوة ذلك القائل
الثاني
أن طلب أبي بكر من المغيرة رضي الله عنهما شاهدا في إرث الجدة دليل على أنه كان يرى أن الحكم متعلق بروايتهما
ولأن عمر رضي الله عنه قال في الجنين لولا هذا لقضينا فيه برأينا وترك رأيه في دية الأصابع بالخبر الذي سمعه
وصرح ابن عمر برجوعهم عن المخابرة بخبر رافع
وصرحوا بأنهم رجعوا إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين لأجل قول عائشة رضي الله عنها
فثبت بمجموع هذين المقامين أن بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لم يعلم صدقه
وأما بيان المقدمتين الباقيتين وهو أنه لم يظهر من أحد منهم الإنكار وأنه متى كان كذلك انعقد الإجماع فتقريره سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة القياس
فإن قيل لا نسلم عمل بعض الصحابة على وفق الخبر الذي لم تعلم صحته
أما دعوى الضرورة فممنوعة قال المرتضى إن الضرورة لا يختص بها البعض مع المشاركة في طريقها والإمامية وكل مخالف في خبر الواحد من النظام وجماعة من شيوخ المتكلمين يخالفونهم فيما ادعوا فيه الضرورة مع الاختلاط بأهل الأخبار ويقسمون على انهم لا يعلمون ذلك ولا يظنونه فإن كذبتموهم فعلتم ما لا يحسن وكلموكم بمثله
وأما الاستدلال فضعيف لأن الروايات التي ذكرتموها وإن بلغت المائة والمائتين فهي غير بالغة إلى حد التواتر فلا تفيد العلم ويرجع حاصله إلى إثبات خبر الواحد بخبر الواحد
سلمنا صحة هذه الروايات لكن لا نسلم أنهم عملوا بتلك الأخبار ولم لا يجوز أن يقال إنهم لما سمعوا تلك الأخبار تذكروا دليلا دلهم على تلك الأحكام
قوله لو كان كذلك لوجب إظهاره من جهة الدين والعادة قلنا لا نزاع في أن ما ذكرتموه هو الاحتمال الأظهر لكن القطع بوجوبه على كل حال ممنوع والمسألة قطعية فلا يجوز بناؤها على مقدمة ظنية
سلمنا عمل بعض الصحابة بهذه الأخبار لكن لا نسلم سكوت الكل عن الإنكار فما الدليل عليه ثم نقول إنهم أنكروه في صور
احداها
توقف رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قوبل خبر ذي اليدين إلى أن شهد له أبو بكر وعمر رضي الله عنهما
وثانيها
رد أبي بكر خبر المغيرة في توريث الجدة حتى أخبره محمد بن مسلمة
وثالثها
رد أبو بكر وعمر خبر عثمان فيما رواه من إذن رسول الله صلى الله عليه و سلم في رد الحكم بن أبي العاص حتى طالباه بمن يشهد
معه به
ورابعها
رد عمر رضي الله عنه خبر أبي موسى الأشعري
حتى شهد له أبو سعيد الخدري
وخامسها
رد عمر خبر فاطمة بنت قيس
وسادسها
رد علي خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق
وأيضا
فقد ظهر عنه تحليف الرواة
وسابعها
رد عائشة خبر بن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه
وثامنها
أن عمر منع أبا هريرة من الرواية سلمنا سكوتهم عن الإنكار لكن السكوت إنما يدل على الإجماع إذا صدر عن الرضا فلم قلت إن الأمر كذلك بل ها هنا احتمالات أخر سوى الرضا من التقية والخوف
سلمنا إجماعهم على قبول الخبر الذي لا يعلم صحته لكن دل على أنهم قبلوا جميع أنواع الخبر الذي يكون كذلك أو على أنهم قبلوه في الجملة
والأول ظاهر الفساد
والثاني يقدح في غرضكم لأنهم لما اتفقوا على قبول نوع
من انواع الخبر الذي لا تعلم صحته لم يلزم من إجماعهم على قبول ذلك النوع إجماعهم على قبول سائر الأنواع لاحتمال أن يأمر الله تعالى بالعمل بذلك النوع دون النوع الآخر ثم إنه لما لم ينقل إلينا ذلك النوع الذي أجمعوا على قبوله لم يعرف ذلك النوع
فإذن لا نوع من أنواع خبر الواحد إلا ولا يدري أنه هل هو ذلك النوع الذي أجمعوا على قبوله أو غيره وإذا كان كذلك وجب التوقف في الكل
سلمنا أن النوع الذي أجمعوا على العمل به معلوم فلم قلت إنه لما جاز لهم العمل بخبر الواحد جاز لنا
بيانه
أن الصحابة كانوا قد شاهدوا الرسول عليه الصلاة و السلام وعرفوا مجاري كلامه ومناهج أموره وإشاراته وعرفوا أحوال أولئك الرواة في العدالة وعدمها في الأفعال الموجبة للعدالة والأفعال المنافية لها
وإذا كان كذلك كان ظنهم بصدق تلك الأخبار وعدالة الرواة أقوى من ظن من لم يشاهد النبي صلى الله عليه و سلم ألبته ولا سمع كلامه ولم يشاهد حال أولئك الرواة فلم يعرف عدالتهم ولا فسقهم إلا بالروايات المتباعدة والوسائط الكثيرة
وإذا كان كذلك فلم قلت إن انعقاد الإجماع على قبول الخبر الذي لا يقطع بصحته عند حصول الظن القوي في صحته يوجب قبوله عندما لا يحصل ذلك الظن القوي
فإن قلت إن كل من قال بقبول بعض هذه الأنواع في بعض الأزمنة قال بقبوله في كل نوع وفي كل زمان
قلت هذه الحجة إنما تنفع في زمان التابعين وقد بينا في أول باب الإجماع أنه لا سبيل إلى القطع بهذا الإجماع لكثرة المسلمين وتفرقهم في الشرق والغرب
والجواب
إما دعوى الضرورة فلما مر تقريرها من أنه نقل إلينا بالتواتر
حضور أبي بكر مع الأنصار يوم السقيفة وتمسكه عليهم بقوله عليه الصلاة و السلام الأئمة من قريش ولم ينكر عليه أحد
فأما قول المرتضى إن النظام وجمعا من شيوخ المعتزلة والقاشاني والإمامية ينكرون ذلك ويقسمون بالله إنهم لا يجدون علما ولا ظنا
قلنا رواية المذاهب لا تجوز بالتشهي واليمين والنظام ما أنكر ذلك بل سلم إلا أنه قال إجماع الصحابة ليس بحجة على ما حكيناه قبل ذلك وكذا قول سائر شيوخ المعتزلة
وأما الإمامية فالأخباريون منهم مع أن كثرة الشيعة في قديم الزمان ما كانت إلا منهم فهم لا يعولون في أصول الدين فضلا عن فروعه إلا على الأخبار التي يروونها
عن أئمتهم
وأما الأصوليون فأبو جعفر الطوسي وافقنا على ذلك فلم يبق ممن ينكر العلم هذا إلا المرتضى مع قليل من أتباعه فلا يستبعد اتفاق مثل هذا الجمع على المكابرة في الضروريات
ومما يحقق ذلك أنه قال إنهم يقسمون بالله على أنهم لا يعلمون بل لا يظنون ونحن نعلم بالضرورة أن هذه الروايات وإن تقاصرت عن العلم إلا أنها ما تقاصرت عن الظن فعلمنا أن غرض المرتضى مما ذكر محض المكابرة
قوله لم لا يجوز أن يقال إنهم عند سماع هذه الأخبار تذكروا دليلا آخر
قلنا لما ذكرنا أن الدين والعادة يوجبان إظهار ذلك الدليل
قوله ما الدليل عليه
قلنا الرجوع فيه إلى العرف فإنا نعلم بالضرورة أن الجمع العظيم إذا اشتبه عليهم أمر من الأمور ثم أنهم عند
سماع شيء يوهم أنه هو الدليل تذكروا شيئا اخر هو الدليل حقيقة فإنه يستحيل اتفاقهم بأسرهم على السكوت عن ذكر ذلك الدليل ورفع ذلك الوهم الباطل قوله من الصحابة من رد خبر الواحد قلنا الجواب عنه من وجهين
الأول
أن الذين نقلتم عنهم أنهم لم يقبلوا خبر الواحد هم الذين نقلنا عنهم أنهم قبلوا فلا بد من التوفيق وما ذاك إلا أن يقال إنهم قبلوا خبر الواحد إذا كان مع شرائط مخصوصة وردوها عند عدم تلك الشرائط
الثاني
أن الروايات التي ذكرتموها كما دلت على ردهم خبر الواحد دلت على قبولهم خبر الإثنين والثلاثة ونحن لم ندع في هذا المقام إلا قبول الخبر الذي لا تقطع بصحته
فأما الأسئلة الثلاثة الأخيرة فالجواب عنها سيأتي في مسألة القياس إن شاء الله تعالى
المسلك الخامس القياس
أجمعوا على أن الخبر الذي لا يقطع بصحته مقبول في الفتوى والشهادات فوجب أن يكون مقبولا في الروايات والجامع تحصيل المصلحة المظنونة أو دفع المفسدة المظنونة بل الروايات أولى بالقبول من الفتوى لأن الفتوى لا تجوز إلا إذا سمع المفتي دليل ذلك الحكم وعرف كيفية الاستدلال به وذلك دقيق صعب يغلط فيه الأكثرون أما الرواية فلا يحتاج فيها إلا إلى السماع فإذن الرواية أحد أجزاء الفتوى فإذا كانت الفتوى مقبولة من الواحد فلأن تكون الرواية مقبولة كان أولى فإن قيل هذا قياس وأنه لا يفيد اليقين على ما تقدم
ثم نقول الفرق بين الفتوى والشهادة وقبول خبر الواحد من وجهين
الأول
وهو أن العمل بخبر الواحد يقتضي صيرورة ذلك الحكم شرعا عاما في حق كل الناس والعمل بالشهادة والفتوى ليس كذلك ولا يلزم من تجويز العمل بالظن الذي قد يخطيء وقد يصيب في حق الواحد تجويز العمل به في حق عامة الخلق
الثاني
العمل بالفتوى ضروري لأنه لا يمكن تكليف كل واحد في كل واقعة بالاجتهاد وكذا الشهادة ضرورية في الشرع لأجل تمييز المحق عن الباطل ( ) أما العمل بخبر الواحد فغير ضروري لأنا إن وجدنا في المسألة دليلا قاطعا عملنا به وإلا رجعنا إلى البراءة الأصلية
ولا يلزم من جواز العمل بالظن عند الضرورة جواز العمل به لا عند الضرورة وأنه قياس فاسد
والجواب
أما السؤال الأول فحق وأما الفرق الأول فملغي بشرعية أصل الفتوى فإنه أمر لكل باتباع الظن وأما الفرق الثاني فضعيف لأنه لا ضرورة في الرجوع إلى الشهادة والفتوى لإمكان الرجوع إلى البراءة الأصلية
المسلك السادس دليل العقل
وهو أن العمل بخبر الواحد يقتضي دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا
بيان المقدمة الأولى
ان الراوي العدل إذا أخبر عن الرسول صلى الله عليه و سلم أنه أمر بهذا الفعل حصل ظن أنه وجد الأمر وعندنا مقدمة يقينية أن مخالفة الأمر سبب لاستحاق العقاب فحينئذ يحصل من ذلك الظن وذلك العلم ظن أنا لو تركنا قوله لصرنا مستحقين للعقاب فوجب أن يجب العمل به لأنه إذا حصل الظن الراجح والتجويز المرجوح فإما أن يجب العمل بهما وهو محال أو يجب تركهما وهو محال أو يجب ترجح المرجوح على الراجح وهو باطل بضرورة العقل او ترجيح الراجح على المرجوح وحينئذ يكون العمل بمقتضى خبر الواحد واجبا واعلم أن هذه الطريقة يتمسك بها في مسألة القياس ونستقصي
الكلام فيها سؤالا وجوابا إن شاء الله تعالى وأما المنكرون فمنهم من عول على العقل ومنهم من عول على النقل أما العقل فمن وجوه
أحدها
لو جاز أن يقول الله تعالى مهما غلب على ظنكم صدق الراوي فاعملوا بمقتضى خبره جاز أن يقول الله تعالى أيضا مهما غلب على ظنكم صذق المدعي للرسالة فاقبلوا شرعه وأحكامه لأنا في كلتا الصورتين نكون عاملين بدليل قاطع وهو إيجاب الله تعالى علينا العمل بالظن أو إيجاب العقل علينا ذلك ولما لم يجز ذلك هناك فكذا ها هنا
وثانيها
لو جاز التعبد بأخبار الآحاد في الفروع لجاز التعبد بها في الأصول حتى يكتفي في معرفة الله تعالى بالظن
وثالثها
الشرعيات مصالح والخبر الذي يجوز كذبه لا يمكن التعويل عليه في تحصيل المصالح فإن قلت لم لا يجوز أن تكون المصلحة هي إيقاع ذلك الفعل المظنون قلت كون الفعل مصلحة إما أن يكون بسبب ذلك الظن أولا بسببة
والأول باطل
لأنه لو جاز أن يوثر ظننا في صيرورة ما ليس بمصلحة مصلحة لجاز أن يؤثر ظننا بمجرد التشهي في ذلك حتى يحسن من الله تعالى أن يقول أطلقت لك في أن تحكم بمجرد التشهي من غير دليل ولا أمارة ومعلوم أنه باطل
وأما الثاني فنقول
إذا كان كون الفعل مصلحة ليس تابعا لظننا فيجوز أن يكون الظن مطابقا وأن لا يكون فيكون الإذن في العمل بالظن إذنا في فعل ما لا يجوز فعله وأنه غير جائز
وأما المعولون على النقل فقد تمسكوا بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إن الظن لا يغني من الحق شيئا
والجواب عن الوجوه العقلية
أنها منقوضة بالعمل بالظن في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية فان من أخبر أن هذا الطعام مسموم و حصل ظن صدقه فإنه لا يجوز تناوله ثم إنا نطالبهم فيها بالجامع العقلي اليقيني ثم ببيان امتناع الجامع
وأيضا
ينتقض بتعويل أهل العالم على الظن في أمر الأغذية والأشربة والعلاجات والأسفار والأرباح
وأما التمسك بالآيات فسيأتي الجواب عنها في القياس إن شاء الله
الباب الثاني
في شرائط العمل بهذه الأخبار
وهذه الشرائط إما أن تكون معتبرة في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر
القسم الأول
في المخبر وهو مرتب على فصول ثلاثة
الفصل الأول
في الأمور التي يجب وجودها حتى يحل للسامع أن يقبل روايته والضابط فيه كونه بحيث يكون اعتقاد صدقه راجحا على اعقاد كذبه ثم نقول تلك الأمور خمسة
الأول
أن يكون عاقلا فإن المجنون والصبي غير المميز لا يمكنه الضبط والاحتراز عن الخلل
والثاني
أن يكون مكلفا وفيه مسألتان
المسألة الأول
رواية الصبي غير مقبولة لثلاثة أوجه
الأول
أن رواية الفاسق لا تقبل فأولى أن لا تقبل رواية الصبي فإن الفاسق يخاف الله تعالى والصبي لا يخاف الله تعالى ألبتة
الثاني
أنه لا يحصل الظن بقوله فلا يجوز العمل به كالخبر عن الأمور الدنيوية
الثالث
الصبي إن لم يكن مميزا لا يمكنه الاحتراز عن الخلل وإن
كان مميزا علم أنه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب فإن قلت أليس يقبل قوله في إخباره عن كونه متطهرا حتى يجوز الاقتداء به في الصلاة قلت ذلك لأن صحة صلاة المأموم غير موقوفة على صحة صلاة الإمام
المسألة الثانية
إذا كان صبيا عند التحمل بالغا عند الرواية قبلت روايته لوجوه أربعة
الأول
إجماع الصحابه فإنهم قبلوا رواية ابن عباس وابن الزبير
والنعمان بن بشير رضي الله عنهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده
الثاني
إجماع الكل على إحضار الصبيان مجالس الرواية
الثالث
أن إقدامه على الرواية عند الكبر يدل ظاهرا على ضبطه للحديث الذي سمعه حال الصغر
الرابع
أجمعنا على أنه تقبل منه الشهادة التي تحملها حال الصغر فكذا الرواية
والجامع أنه حال الأداء مسلم عاقل بالغ يحترز من الكذب
الشرط الثالث
أن يكون مسلما وفيه مسألتان
المسألة الأولى
الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة أجمعت الأمة على أنه لا تقبل روايته سواء علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب أو لم يعلم
المسألة الثانية
المخالف من أهل القبلة إذا كفرناه كالمجسم وغيره هل تقبل روايته أم لا الحق أنه إن كان مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته وإلا قبلناها وهو قول أبى الحسين البصري وقال القاضي أبو بكر والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم
لنا
أن المقتضي للعمل به قائم ولا معارض فوجب العمل به بيان أن المقتضي قائم أن اعتقاده تحريم الكذب يزجره عن الإقدام عليه فيحصل ظن صدقه فيجب العمل به على ما بيناه وبيان أنه لا معارض أنهم أجمعوا على أن الكافر الذي ليس من أهل القبلة لا تقبل روايته وذلك الكفر منتف ها هنا
واحتج أبو الحسين
بأن كثيرا من أصحاب الحديث قبلوا أخبار سلفنا كالحسن وقتادة وعمرو بن عبيد مع علمهم بمذهبهم وإكفارهم من يقول بقولهم
واحتج المخالف بالنص والقياس
أما النص فقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أمر بالتثبت عند نبأ الفاسق وهذا كافر فوجب التثبت عند خبره وأما القياس فأجمعنا على أن الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة لا تقبل روايته فكذا هذا الكافر والجامع أن قبول الرواية تنفيذ لقوله على كل المسلمين وهو منصب شريف والكفر يقتضي الإذلال وبينهما منافاة أقصى ما في الباب أن يقال هذا الكافر جاهل بكونه كافرا لكنه لا يصلح عذرا لأنه ضم إلى كفره جهلا اخر وذلك لا يوجب رجحان حاله على الكافر الأصلي
والجواب عن الأول
أن اسم الفاسق في عرف الشرع مختص بالمسلم
المقدم على الكبيرة
وعن الثاني
الفرق بين الموضعين أن كفر الخارج عن الملة أعظم من
كفر صاحب التأويل فقد رأينا الشرع فرق بينهما في أمور كثيرة مع ظهور الفرق لا يجوز الجمع
الشرط الرابع
العدالة وهي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفس بصدقه ويعتبر فيها الاجتناب عن الكبائر وعن بعض الصغائر كالتطفيف في الحبة وسرقة باقة من البقل وعن المباحاث القادحة في المروءة كالأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل والإفراط في المزاح والضابط فيه أن كل ما لا يؤمن معه جرأته على الكذب ترد به الرواية وما لا فلا ويتفرع على هذا نوعان من الكلام
النوع الأول في أحكام العدالة
وفيه مسائل
المسألة الأولى
الفاسق اذا أقدم على الفسق فإن علم كونه فسقا لم تقبل روايته بالإجماع وإن لم يعلم كونه فسقا فكونه فاسقا إما أن يكون مظنونا أو مقطوعا فإن كان مظنونا قبلت روايته بالاتفاق قال الشافعي رضي الله عنه أقبل شهادة الحنفي وأحده إذا شرب
النبيذ وإن كان مقطوعا به قبلت روايته أيضا قال الشافعي رضي الله عنه أقبل رواية أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم
وقال القاضي أبو بكر لا تقبل
لنا
أن ظن صدقه راجح والعمل بهذا الظن واجب والمعارض
المجمع عليه منتف فوجب العمل به
واحتج الخصم
بأن منصب الرواية لا يليق بالفاسق أقصى ما في الباب أنه جهل فسقه ولكن جهله بفسقه فسق آخر فإذا منع أحد الفسقين من قبول الرواية فالفسقان أولى بذلك المنع
والجواب
أنه إذا علم كونه فسقا دل إقدامه عليه على اجترائه على المعصية بخلاف ما إذا لم يعلم ذلك
المسألة الثانية
المخالف الذي لا نكفره ولكن ظهر عناده لا تقبل روايته لأن المعاند يكذب مع علمه بكونه كذبا وذلك يقتضي جرأته على الكذب فوجب أن لا تقبل روايته
المسألة الثالة قال الشافعي رضي الله عنه رواية المجهول غير مقبولة بل لا بد فيه من خبرة ظاهرة والبحث عن سيرته وسريرته وقال أبو حنيفة رحمة الله وأصحابه يكفي في قبول الرواية الإسلام بشرط سلامة الظاهر عن
الفسق
لنا أوجه
الأول
الدليل ينفي العمل بخبر الواحد لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا خالفناه في حق من اختبرناه لأن الظن هناك أقوى فيبقى في المجهول على الأصل
الثاني
الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد إلا إذا قطعنا بأن
الراوي ليس بفاسق ترك العمل به فيما غلب على ظننا أنه ليس بفاسق بسبب كثرة الاختبار فيبقى فيما عداه على الأصل
بيان الثاني
أن عدم الفسق شرط جواز الرواية فوجب أن يكون العلم به شرطا لجواز الرواية وإنما قلنا إن عدم الفسق شرط جواز الرواية لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهو صريح في المنع من قبول رواية الفاسق وإنما قلنا إن عدم الفسق لما كان شرطا لجواز الرواية وجب ان يكون العلم به شرطا لجواز الرواية لأن الجهل بالشرط
يوجب الجهل بالمشروط
وبيان الفارق
أن العدالة أمر كامن في الباطن لا اطلاع عليه حقيقة بل الممكن فيه الاستدلال بالأفعال الظاهرة وذلك وإن لم يفد العلم لكنه يفيد الظن ثم الظن الحاصل بعد طول الاختبار أقوى من الظن الحاصل قبله وإذا كان كذلك لم يلزم من مخالفة الدليل عند وجود المعارض القوي مخالفته عند وجود المعارض الضعيف
الثالث
أجمعنا على أنه لما كان الصبا والرق والكفر وكونه محدودا في القذف مانعا من الشهادة لا جرم اعتبر في قبول الشهادة العلم بعدم هذه الأشياء ظاهرا فوجب أن يكون الأمر كذلك
في العدالة والجامع الاحتراز عن المفسدة المحتملة
الرابع
إجماع الصحابة رضي الله عنهم على رد رواية المجهول رد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس وقال كيف نقبل قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ورد علي رضي الله عنه خبر الأشجعي في المفوضة وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحلف الراوي ثم إن أحدا من الصحابة ما أظهر الإنكار على ردهم وذلك يقتضي حصول الإجماع
و احتج المخالف بأمور
أحدها
أنه يقبل قول المسلم في كون اللحم لحم المذكى وفي
كون الماء في الحمام طاهرا وفي كون الجارية المبيعة رقيقة وفي كون المرأة غير مزوجة ولا معتدة وفي كونه على الوضوء إذا أم الناس وفي إخباره للأعمى عن القبلة فكذا ها هنا
وثانيها
أن الصحابة قبلت قول العبيد والصبيان والنسوان لأنهم عرفوهم لا بالاسلام وما عرفوهم بالفسق
وثالثها
أنه عليه الصلاة و السلام قبل شهادة الأعرابي على رؤية الهلال مع أنه لم يظهر منه إلا الإسلام
ورابعها
قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا والمعلق على شرط عدم عند عدم الشرط فما لم يعلم فسقه لم يجب التثبت
والجواب عن الأول
لم قلتم إنه لما قبل قول المجهول في تلك الصور قبل قوله في الرواية والفرق أن منصب الرواية أعلى من تلك المناصب فإن ألغوا هذه الزيادة بإيماء قوله عليه الصلاة و السلام نحن نحكم بالظاهر قلنا ترك العمل بهذا الإيماء في الكفر
والحرية فكذا ها هنا
وعن الثاني
لا نسلم أن الصحابة قبلت قول المجاهيل فإن هذا هو نفس المسألة
وعن الثالث
لا نسلم أنه عليه الصلاة و السلام ما كان يعرف من حال ذلك الأعرابي إلا مجرد الاسلام
وعن الرابع
لما وجب التوقف عند قيام المفسق وجب أن نعرف أنه في نفسه هل هو فاسق أم لا حتى يمكننا أن نعرف أنه هل يجب التوقف في قوله أم لا
النوع الثاني
في طريق معرفة العدالة والجرح وهو أمران
احدهما الاختبار
وثانيهما التزكية
والمقصود ها هنا بيان احكام التزكية والجرح
وفيه مسائل
المسألة الأولى
شرط بعض المحدثين العدد في المزكي والجارح في الرواية والشهادة وقال القاضي أبو بكر لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي وقال قوم يشترط في الشهادة دون الرواية وهو الأظهر لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية
وشرط الشيء لا يزيد على أصله فالإحصان يثبت بقول اثنين وإن لم يثبت الزنا إلا بقول اربعة وكذلك نقول تقبل تزكية العبد والمرأة في الرواية كما يقبل قولهما
المسألة الثانية
قال الشافعي رضي الله عنه يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل لأنه قد يجرح بما لا يكون جارحا لاختلاف المذاهب فيه وأما العدالة فليس لها إلا سبب واحد
وقال قوم يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح لأن مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر فلا بد من سبب وقال قوم لا بد من السبب فيهما جميعا أخذا بمجامع كلام الفريقين وقال القاضي أبو بكر لا يجب ذكر السبب فيهما جميعا لأنه إن لم يكن بصيرا بهذا الشأن لم تصح تزكيته وإن كان بصيرا فلا معنى للسؤال والحق أن هذا يختلف باختلاف أحوال المزكي فإن علمنا
كونه عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه وإن علمنا عدالته في نفسه ولم نعرف اطلاعه على شرائط الجرح والتعديل استخبرناه عن أسباب الجرح والتعديل
المسألة الثالثة
إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح لأنه اطلاع على زيادة لم يطلع عليها المعدل ولا نفاها فإن نفاها بطلت عدالة المزكي إذا النفي لا يعلم اللهم إلا إذا جرحه بقتل انسان فقال المعدل رأيته حيا فها هنا يتعارضان وعدد المعدل إذا زاد قيل إنه يقدم على الجارح وهو
ضعيف لأن سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على زيادة فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد
المسألة الرابعة
للتزكية مراتب أربعة
أعلاها أن يحكم بشهادته
والثانية أن يقول هو عدل لأني عرفت منه كيت وكيت فإن لم يذكر السبب وكان عارفا بشروط العدالة كفى
والثالثة أن يروي عنه خبرا واختلفوا في كونه تعديلا والحق أنه إن عرف من عادته أو بصريح قوله أنه
لا يستجيز الرواية إلا عن عدل كانت الرواية تعديلا وإلا فلا إذ من عادة أكثرهم الرواية عن كل من سمعوه ولو كلفوا الثناء عليهم سكتوا فإن قلت لو عرفه بالفسق ثم روى عنه كان غاشا في الدين قلت انه لم يوجب على غيره العمل به بل قلت سمعت فلانا يقول كذا وصدق فيه ثم لعله لم يعرفه بالفسق ولا بالعدالة فروى ووكل البحث إلى من أراد القبول
والرابعة العمل بالخبر إن أمكن حملة على الاحتياط أو على العمل بدليل اخر وافق الخبر فليس بتعديل وإن عرف يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل إذ لو عمل بخبر غير العدل لفسق
المسألة الخامسة
ترك الحكم بشهادته لا يكون جرحا في روايته وذلك لأن
الرواية والشهادة مشتركتان في هذه الشرائط الأربعة أعني العقل والتكليف والاسلام والعدالة واختصت الشهادة بأمور ستة هي غير معتبرة في الرواية وهي عدم القرابة و الحرية والذكورة والبصر والعدد والعداوة والصداقة فهذه الستة توثر في الشهادة لا في الرواية لأن الولد له أن يروي عن والده بالإجماع والعبد له أن يروي أيضا والضرير له أن يروي أيضا ذلك لأن الصحابة رووا عن زوجات النبي صلى الله عليه و سلم مع أنهم في حقهن كالضرير
الشرط الخامس
أن يكون الراوي بحيث لا يقع له الكذب والخطأ وذلك يستدعي
حصول امرين
أحدهما
أن يكون ضابطا
والآخر
أن لا يكون سهوه أكثر من ذكره ولا مساويا له أما ضبطه فلأنه إذا عرف بقلة الضبط لم تؤمن الزيادة والنقصان في حديثه ثم هذا على قسمين
أحدهما
أن يكون مختل الطبع جدا غير قادر على الحفظ أصلا ومثل هذا الإنسان لا يقبل خبره ألبتة
والثاني
أن يقدر على ضبط قصار الآحاديث دون طوالها وهذا الإنسان يقبل منه ما عرف كونه قادرا على ضبطه دون ما لا يكون قادرا عليه
أما إذا كان السهو غالبا عليه لم يقبل حديثه لأنه يترجح أنه سها في حديثه وأما إذا استوى الذكر والسهو لم يترجح أنه ما سها والفرق بين أن لا يكون ضابطا وبين أن يعرض له السهو أن من لا يضبط لا يحصل الحديث حال سماعه ومن يعرض له السهو قد يضبط الحديث حال سماعه وتحصيله إلا أنه قد يشذ عنه بعارض السهو فإن قلت لم لا يجوز أن يقبل حديثه لأنه لو لم يكن ضبطه أو ضبطه ثم سها عنه لم يروه مع عدالته قلت عدالته تمنع من الكذب والخطأ عمدا لا سهوا فجاز أن يتصور مع عدالته فيما لم يضبطه أنه ضبطه وانه لم يسه فيما سها عنه فوجب أن لا يقبل حديثه
الفصل الثاني
في الأمور التي يجب ثبوتها حتى يحل للراوي أن يروي الخبر اعلم ان لذلك مراتب
فأعلاها
أن يعلم أنه قرأه على شيخه أو حدثه به ويتذكر ألفاظ قراءته ووقت ذلك فلا شبهة في أنه يجوز له روايته والأخذ به
وثانيها
أن يعلم أنه قرأ جميع ما في الكتاب أو حدثه به ولا يتذكر ألفاظ قراءته ولا وقت ذلك فيجوز له روايته لأنه عالم في الحال أنه سمعه
وثالثها
أن يعلم أنه لم يسمع ذلك الكتاب ولا يظن أيظا أنه سمعه أو يجوز الأمرين تجويزا على السوية فلا تجوز له روايته لأنه لا يجوز له أن يخبر بما يعلم أنه كاذب فيه أو ظان أو
شاك فيه
ورابعها
أن لا يتذكر سماعه ولا قراءته لما فيه لكنه يظن ذلك لما يرى من خطه وها هنا اختلفوا فيه فعند الشافعي رضي الله عنه تجوز له روايته وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تجوز
لنا
الإجماع والمعقول
أما الإجماع فهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تعمل على كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم نحو كتابه لعمرو بن حزم من غير أن يقال إن راويا روى ذلك الكتاب لهم وإنما علموا ذلك لأجل الخط وأنه منسوب إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فجاز مثله في سائر الروايات
وأما المعقول فلأن الظن حاصل ها هنا والعمل بالظن واجب
احتج أبو حنيفة رحمه الله
بأنه إذا لم يعلم السامع لم يؤمن الكذب
جوابه
أنه يروي بحسب الظن وذلك يكفي في وجوب العمل
الفصل الثالث
فيما جعل شرطا في الراوي مع أنه غير معتبر والضابط في هذا الباب كل خصلة لا تقدح في غالب الظن بصحة الرواية ولم يعتبر الشرع تحقيقها تعبدا فإنها لا تمنع من قبول الخبروفيه مسائل
المسألة الأولى
رواية العدل الواحد مقبولة خلافا للجبائي فإنه قال رواية العدلين مقبولة
وأما خبر العدل الواحد فلا يكون مقبولا إلا إذا عضده ظاهر أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو يكون منتشرا فيهم
وحكى عنه القاضي عبد الجبار أنه لم يقبل في الزنا
إلا خبر أربعة كالشهادة عليه
لنا وجهان
الأول
إجماع الصحابة عمل أبو بكر على خبر بلال وعمل عمر على خبر حمل بن مالك وعلى خبر عبد الرحمن في المجوس وعمل علي على خبره المقداد وعملت الصحابة على خبر أبي سعيد في الربا وعملت على خبر رافع ابن خديج في المخابرة وعلى خبر عائشة في التقاء الختانين وكان علي يقبل خبر أبي بكر رضي الله عنهم اجمعين
فإن قلت لعلهم قبلوا ما قبلوه لأن الاجتهاد عضده
قلت إنهم كانوا يتركون اجتهادهم بهذه الأخبار وكانوا
لا يرون بالمخابرة بأسا حتى روى لهم رافع بن خديج نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها
الثاني
أن العمل بخبر الواحد العدل يتضمن دفع ضرر مظنون فيكون واجبا
احتج الخصم بأمور
أحدها
أنه عليه الصلاة و السلام لم يقبل خبر ذي اليدين حتى شهد له أبو بكر وعمر رضي الله عنهم
وثانيها
أن الصحابة إعتبرت العدد فإن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة في الجدة حتى رواه معه محمد بن مسلمة
ولم يعمل عمر على خبر أبي موسى في الاسئذان حتى رواه أبو سعيد الخذري
ورد خبر فاطمة بنت قيس
ورد أبو بكر وعمر خبر عثمان رضي الله عنهم أجمعين في رد الحكم بن العاص
وثالثها
قياس الرواية على الشهادة بل أولى لأن الرواية تقتضي شرعا عاما والشهادة شرعا خاصا فإذا لم تقبل رواية الواحد في حق الإنسان الواحد فلأن لا تقبل في حق كل الأمة كان أولى
ورابعها
الدليل ينفي العمل بالخبر المظنون لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا ترك العمل به في خبر العدلين والعدل الواحد ليس في معناه لأن الظن هناك أقوى مما ها هنا فوجب أن يبقى على الأصل
والجواب عن الأول
أن ذلك إن دل فإنما يدل على اعتبار ثلاثة أبي بكر وعمر وذي اليدين رضي الله عنهم ولأن التهمة كانت قائمة هناك لأنها كانت واقعة في محفل عظيم والواجب فيها الاشتهار
وعن الثاني
أن بينا أنهم قبلوا خبر الواحد وها هنا اعتبروا العدد فلا بد من التوفيق فنقول ما ذكرناه من الروايات يدل على أن العدد ليس بشرط في أصل الرواية وما ذكروه دل على أنهم طلبوا العدد لقيام تهمة في تلك الصور
وعن الثالث
أنه منقوض بسائر الأمور التي هي معتبرة في الشهادة لا في
الرواية كالحرية والذكورة والبصر وعدم القرابة
عن الرابع
لا نسلم أن قول الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا يمنع من التعلق بخبر الواحد فإنا لما علمنا أن الله تعالى أمرنا بالتمسك كان تمسكنا به معلوما لا مظنونا
المسألة الثانية
زعم أكثر الحنفية أن راوي الأصل إذا لم يقبل الحديث قدح ذلك في رواية الفرع
والمختار أن نقول راوي الفرع إما أن يكون جازما بالرواية أو لا يكون
فإن كان جازما فالأصل إما أن يكون جازما بفساد الحديث أو بصحته أو لا يجزم بواحد منهما
فإن كان الأول فقد تعارضا فلا يقبل الحديث ولأن قبول الحديث من الفرع لا يمكن إلا بالقدح في الأصل وذلك يوجب القدح في الحديث
وأما الثاني فلا نزاع في صحته
وأما الثالث
فإما أن يقول الأغلب على ظني أني ما رويته أو الأغلب أني رويته أو الأمران على السواء أو لا يقول شيئا من ذلك
ويشبه أن يكون الخبر في كل هذه الأقسام مقبولا لأن الفرع جازم ولم يوجد في مقابلته جزم يعارضه فلا يسقط به الاستدلال
وأما إذا لم يكن الفرع جازما بل يقول أظن أني سمعته منك فإن جزم الأصل بأني ما رويته لك تعين الرد وان قال اظن انى ما رويته لك تعارضا والأصل العدم
وإن ذهب إلى سائر الأقسام فالأشبه قبوله
والضابط أنه حيث يكون قول الأصل معادلا بقول الفرع تعارضا وحيث ترجح أحدهما على الآخر فالمعتبر هو الراجح
و احتج المانعون مطلقا
بأن الدليل ينفي قبول خبر الواحد فالفناه فيما إذا لم يوجد هذا المعنى لأن الظن هناك فيبقى فيما عداه على الأصل
والجواب ما تقدم
المسألة الثالثة
لا يشترط كون الراوي فقيها سواء كانت روايته موافقه للقياس أو مخالفة له خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فيما يخالف القياس
لنا
الكتاب والسنه والعقل
أما الكتاب فقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فوجب أن لا يجب التبين في غير الفاسق سواء كان عالما أو جاهلا
وأما السنة فقوله صلى الله عليه و سلم نضر الله أمرءا سمع مقالتي فوعاها إلى قوله فرب حامل فقه ليس بفقيه
وأما العقل فهو أن خبر العدل يفيد ظن الصدق فوجب العمل به لما تقدم من أن العمل بالظن واجب
واحتج الخصم بوجهين
الأول
أن الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد خالفناه
إذا كان الراوي فقيها لأن الاعتماد على روايته أوثق
الثاني
أن الأصل أن لا يرد الخبر على مخالفة القياس والأصل أيضا صدق الراوي فإذا تعارضا تساقطا ولم يجز التمسك بواحد منهما
وأيضا
فبتقدير صدق الراوي لا يلزم القطع بكون ذلك الخبر حجة لأنه إذا جرى حديث منافق عند الرسول صلى الله عليه و سلم فإذا جاء ذلك الرجل فقال الرسول صلى الله عليه و سلم اقتلوا الرجل علم الفقيه أن الألف واللام ها هنا ينصرف إلى المعهود والعامي ربما ظن أن المراد منه الاستغراق
والجواب عن الأول ما مر
وعن الثاني
أن في التعارض تسليما بصحة أصل الخبر
قوله يجوز أن يشتبه عليه المعهود بالاستغراق
قلنا التمييز بين الأمرين لا يتوقف على الفقه بل كل من كانت له فطنه سليمة أمكنه التمييز بين الأمرين
وأيضا
فإن ذلك يقتضي اعتبار الفقه في رواة خبر التواتر
المسألة الرابعة
إذا عرف منه التساهل في أمر حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا خلاف في أنه لا يقبل خبره
وأما إذا عرف منه التساهل في غير حديث رسول الله
صلى الله عليه و سلم وعرف منه الاحتياط جدا في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم وجب قبول خبره على الرأي الأظهر لأنه يفيد الظن ولا معارض فوجب العمل به
المسألة الخامس
لا يعتبر في الراوي أن يكون عالما بالعربية وبمعنى الخبر لأن الحجة في لفظ الرسول عليه الصلاة و السلام والأعجمي والعامي يمكنهما حفظ اللفظ وكذلك يمكنهما حفظ القرآن
ولا يعتبر أيضا أن يكون ذكرا أو حرا أو بصيرا وهو مجمع عليه
المسألة السادسة
تقبل رواية من لم يرو إلا خبرا واحدا
فأما إذا أكثر من الروايات مع قلة مخالطته لأهل الحديث فإن أمكن تحصيل ذلك القدر من الأخبار في ذلك القدر من الزمان قبلت أخباره وإلا توجه الطعن في الكل
المسألة السابعة
لا يجب كون الراوي معروف النسب بل إذا حصلت الشرائط المعتبرة المذكورة فيه قبل خبره وإن لم يعرف نسبه
وأما إذا كان له اسمان وهو بأحدهما أشهر جازت الرواية عنه
وأما اذا كان مترددا بينهما وهو بأحدهما مجروج وبالآخر معدل لم يقبل لأجل التردد
القسم الثاني في البحث عن الأمور العائدة إلى المخبر عنه
اعلم أن الشرط العائد إلى المخبر عنه في العمل بالخبر هو عدم دليل قاطع يعارضه
والمعارض على وجهين
أحدهما
أن ينفي أحدهما ما أثبته الآخر على الحد الذي أثبته الآخر كما إذا قال في أحدهما ليصل فلان في الوقت الفلاني على الوجه الفلاني وينهى في الثاني عن ذلك الحد في ذلك الوقت
وثانيهما
أن يثبت أحدهما ضد ما أثبته الآخر على الحد الذي أثبته الآخر مثل أن يوجب عليه صلاة أخرى في عين ذلك الوقت في غير ذلك المكان
والدليل القاطع ضربان عقلي وسمعي
فإن كان المعارض عقليا نظرنا فإن كان خبر الواحد قابلا للتأويل كيف كان أولناه فلم نحكم برده وإن لم يقبل التأويل قطعنا بفساده لأن الدالة العقلية غير محتملة للنقيض
فإذا كان خبر الواحد غير محتمل للنقيض في دلالته وهو محتمل للنقيض في متنه قطعنا بوقوع ذلك المتحمل وإلا فقد وقع الكذب من الشرع وإنه غير جائز
وأما أدلة السمع فثلاثه الكتاب والسنة المتواترة والإجماع وأعلم أنه لا يستحيل عقلا أن يقول الله تعالى أمرتكم بأن تعملوا بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع بشرط أن لا يرد خبر واحد على مناقضته فإذا ورد ذلك فيكفيكم أن تعملوا بخبر الواحد
لا بهذه الأدلة لكن الإجماع عرفنا أن هذا المحتمل لم يقع لأن الإجماع منعقد على أن الدليلين إذا استويا ثم اختص أحدهما بنوع قوة غير حاصل في الثاني فإنه يجب تقديم الراجح
فها هنا هذه الأدلة الثلاثة لما كانت مساوية لخبر الواحد في الدلالة واختصت هذه الأدلة الثلاثة بمزيد قوة وهي بكونها قاطعة في متنها لا جرم وجب تقديمها على خبر الواحد
وأما أن خبر الواحد هل يقتضي تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة فقد تقدم القول فيه
القول فيما ظن أنه شرط في هذا الباب وليس بشرط
المسألة الأولى
خبر الواحد إذا عارضه القياس فإما أن يكون خبر الواحد يقتضي تخصيص القياس أو القياس يقتضي تخصيص خبر الواحد
وإما أن يتنافيا بالكلية
فإن كان الأول فمن يجيز تخصيص العلة يجمع بينهما
ومن لا يجيزه يجري هذا القسم مجرى ما إذا تنافيا بالكلية
وإن كان الثاني كان ذلك تخصيصا لعموم خبر الواحد بالقياس وأنه جائز لأن تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس لما كان جائزا فها هنا أولى
وأما الثالث وهو ما إذا كان كل واحد منهما مبطلا لكل مقتضيات الآخر فنقول
ذلك القياس لا بد وأن يكون أصله قد ثبت بدليل وذلك الدليل إما أن يكون هو ذلك الخبر أو غيره
فإن كان الأول فلا نزاع أن الخبر مقدم على القياس وإن كان الثاني فهذا يحتمل وجوها ثلاثة وذلك لأن القياس
يستدعي أمورا ثلاثة
أحدها ثبوت حكم الأصل
وثانيها كونه معللا بالعلة الفلانية
وثالثها حصول تلك العلة في الفرع
ثم لا يخلو كل واحد من هذه الثلاثة إما أن تكون قطعية أو ظنية أو بعضها قطعي وبعضها ظني
فإن كان الأول كان القياس مقدما على خبر الواحد لا محالة لأن هذا القياس يقتضي القطع وخبر الواحد يقتضي الظن ومقتضى القطع مقدم على مقتضى الظن
وإن كان الثاني كان الخبر لا محالة مقدما على القياس لأن الظن كلما كان أقل كان بالأعتبار أولى
وإن كان الثالث فهذا يحتمل أقساما كثيرة ونحن نعين منها صورة واحدة وهي أن يكون دليل ثبوت الحكم في الأصل قطعيا إلا أن كونه معللا بالعلة المعينة ووجود تلك العلة في الفرع ظنيا فها هنا اختلفوا
فعند الشافعي رضي الله عنه الخبر راجح
وعند مالك رحمه الله القياس راجح
وقال عيسى بن أبان إن كان راوي الخبر ضابطا عالما وجب تقديم خبره على القياس وإلا كان في غير محل الاجتهاد
وقال أبو الحسن البصري طريق ترجيح أحدهما على الآخر الاجتهاد فإن كانت أمارة القياس أقوى عنده من عدالة الراوي وجب المصير إليها وإلا فبالعكس
ومن الناس من توقف فيه
لنا وجوه
الأول
أن الصحابة كانوا يتركون اجتهادهم لخبر الواحد من ذلك قصة عمر رضي الله عنه في الجنين حتى قال كدنا نقضي فيه برأينا وفيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
وأيضا ترك اجتهاده في المنع من توريث المرأة من ديه زوجها
وأيضا قال أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا
وأيضا فإن أبا بكر رضي الله عنه
نقض حكما حكم فيه برأيه لحديث سمعه من بلال
فإن قلت إن أبن عباس رد خبر أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه حتى قال فما نصنع بمهراسنا
قلت ظاهر هذا القول لا يقتضي رد الخبر وإنما هو وصف للمشقة في العمل بموجبه مع عظم المهراس
سلمنا أنه ترك هذا الحديث لكن إنما تركه لأنه لا يمكن الأخذ به من حيث لا يمكن قلب المهراس على اليد
فإن قلت ليس فيه تكليف ما لا يطاق لأنه كان يمكنهم غسل أيديهم من إناء اخر ثم ادخالها في المهراس
قلت ومن أين يعلم أن قياس الأصول يقضي غسل اليدين من ذلك الإناء حتى يكون قد رد الخبر لذلك القياس
الثاني
أن قصة معاذ تقتضي تقديم الخبر على القياس
الثالث
أن التمسك بالخبر لا يتم إلا بثلاث مقدمات
إحداها
ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
وثانيتها
دلالته على الحكم
وثالثها
وجوب العمل به والمقدمة الأولى ظنية والثانية والثالثة يقينية
و أما التمسك بالقياس فلا يتم إلا بخمسن مقدمات
أحداها
ثبوت حكم الأصل
وثانيتها
كونه معللا بالعلة الفلانية
وثالثتها
حصول تلك العلة في الفرع
ورابعتها
عدم المانع في الفرع عند من يجيز تخصيص العلة
وخامستها
وجوب العمل بمثل هذه الدلالة
والمقدمة الأولى والخامسة يقينية
وأما الثانية والثالثة والرابعة فظنية
وإذا كان كذلك كان العمل بالخبر أقل بالخبر أقل ظنا من العمل بالقياس فوجب أن يكون الخبر راجحا
فإن قلت إذا كانت الأمارة الدالة على ثبوت الخبر عن الرسول صلى الله عليه و سلم ضعيفة والإمارات الدالة على المقدمات الثلاثة الظنية في جانب القياس قوية بحيث يتعارض ما في أحد الجانبين من الكمية بما في الجانب الآخر من الكيفية فها
هنا يتعين الاجتهاد والرجوع إلى الترجيح
قلت لو خلينا والعقل لكان الأمر كما ذكرت إلا أن الدليلين الأولين منعا منه
المسألة الثانية إذا روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه عمل بخلاف موجب الخبر فالخبر إما أن يكون متناولا للرسول صلى الله عليه و سلم أو غير متناول له
فإن لم يتناوله لم يخل من أن يكون قد قامت الدلالة على أن حكمنا وحكمه صلى الله عليه و سلم فيه سواء أو لم تقم الدلالة على ذلك
فإن لم يقم عليه دليل جاز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم مخصوصا بذلك الحكم وعلى هذا التقدير لا يكون بين فعله وبين الخبر تناف فلا يرد الخبر لأجله
وإن قامت الدلالة على أن حكمه صلى الله عليه و سلم وحكمنا فيه سواء نظر في الخبرين فإن أمكن تخصيص أحدهما بالآخر فعل وإن لم يمكن كان أحدهما متواترا عمل بالتواتر
وإن لم يكونا متواترين عمل فيهما بالترجيح
المسألة الثالثة
عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب رده
وعمل أكثر الأمة بموجب الخبر لا يوجب قبوله لأن أكثر الأمة بعض الأمة وقول بعض الأمة ليس بحجة إلا أن ذلك وإن لم يكن حجة فإنه من المرجحات
المسألة الرابعة
الحفاظ إذا خالفوا الراوي في بعض ذلك الخبر فقد اتفقوا على أن ذلك لا يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفوه فيه
لأن ظاهر حاله الصدق ولم يوجد معارض فوجب قبوله
وأما القدر الذي خالفوه فيه فالأولى أن لا يقبل لأنه وإن جاز أن يكونوا سهوا وحفظ هو لكن الأقوى أنه سها وحفظوا هم لأن السهو على الواحد أجوز منه على الجماعة
المسألة الخامسة
خبر الواحد إذا تكاملت شروط صحته هل يجب عرضه على الكتاب
قال الشافعي رضي الله عنه لا يجب لأنه لا تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب
وعند عيسى بن أبان يجب عرضه عليه لقوله صلى الله عليه و سلم إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه
المسألة السادسة
لا شبهة في أن الناسخ يجب أن يكون غير مقارن للكتاب فإن علم أن خبر الواحد غير مقارن للكتاب لم يقبل لما ثبت أن نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز
وإن شك فيه قبل عند القاضي عبد الجبار قال لأن الصحابة رفعت بعض أحكام القرآن لأخبار الآحاد ولم تسأل هل كانت مقارنة أم لا
المسألة السابعة
اختلفوا فيما إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته
فالأول
هو قول بعض الحنفية الراوي للحديث العام إذا خصه رجع إليه لأنه لما شاهد الرسول صلى الله عليه و سلم كان أعرف بمقاصده ولذلك حملوا رواية أبي هريرة في ولوغ الكلب أنه يغسل سبعا على الندب لأن أبا هريرة كان يقتصر على الثلاث
الثاني
وهو قول الكرخي أن ظاهر الخبر أولى
والثالث
أنه إن كان تأويل الراوي بخلاف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث
وإن كان هو أحد محتملات الظاهر رجع إلى تأويله وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه
والرابع
وهو قول القاضي عبد الجبار إن لم يكن لمذهبه وتأويله وجه إلا أنه علم بالضرورة قصد النبي صلى الله عليه و سلم إليه وجب المصير إليه
وإن لم يعلم ذلك بل جوزنا أن يكون قد صار إليه لنص أو قياس وجب النظر في ذلك فإن اقتضى ما ذهب إليه صير إليه وإلا فلا
وكذا إن كان الحديث مجملا وبينه الراوي كان بيانه أولى
حجة الشافعي رضي الله عنه أن المقتضى وهو ظاهر اللفظ قائم والمعارض الموجود وهو مخالفة الراوي لا يصلح أن يكون معارضا لاحتمال أن يكون قد تمسك في تلك المخالفة بما ظنه دليلا مع أنه لا يكون كذلك
فإن قلت الظاهر من دينه أنه لا يخالف إلا لدليل
قلت دينه يمنعه عن الخطأ عمدا لا سهوا وغلطا وليس ها هنا ظاهر يدل على أنه كان من العلم بحيث لا يعرض له ذلك الخطأ
المسألة الثامنة
خبر الواحد إما أن يقتضي علما أو عملا
فإن اقتضى علما فإما أن يكون في الأدلة القاطعة ما يدل عليه أو لا يكون
فإن كان الأول جاز قوله لأنه لا يمتنع أن يكون عليه الصلاة و السلام قاله واقتصر به على آحاد الناس واقتصر بغيرهم على الدليل الآخر
وإن كان الثاني وجب رده سواء اقتضى مع العلم عملا أو لم يقتضه لأنه لما كان التكليف فيه بالعلم مع أنه ليس له صلاحية
إفاده العلم كان ذلك تكليفا بما لا يطاق اللهم إلا أن يقال لعله عليه الصلاة و السلام أوجب العلم به على من شافهه دون من لم يشافهه فإن ذلك جائز
فأما إذا اقتضى عملا وكان البلوي به عاما فعندنا لا يجب رده
وعند الحنفية يجب رده
لنا وجوه
أحدها
عموم قوله تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
وثانيها
أن خبر الواحد العدل في هذا الباب يفيد ظن الصدق فيكون العمل دافعا
لضرر مظنون فيكون واجبا
وثالثها
رجوع الصحابة إلى عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين مع أن ذلك مما تعم به البلوي
ورابعها
أن البلوي عام بمعرفة أحكام القيء والرعاف والقهقهة في الصلاة ووجوب الوتر مع أنهم يقبلون خبر الواحد فيه وليس يعصمهم من ذلك أنه قد تواتر النقل بالوتر لأن وجوبها يعم به البلوي ولم يتواتر نقله
واحتجوا بالإجماع والمعقول
أما الإجماع فهو أن أبا بكر رد حديث المغيرة في الجدة ورد عمر خبر أبي موسى في الاسئذان
وأما المعقول فهو أنه لو كان صحيحا لأشاعه الرسول صلى الله عليه و سلم ولأوجب نقله على جهة التواتر مخافة أن لا يصل إلى من كلف به فلا يتمكن من العمل به ولو فعل ذلك لتوافرت الدواعي إلى نقله على جهة التواتر
والجواب عن الأول
أنه أنما كان يجب ذلك الذي قلتم لو لم يقبلوا فيه إلا خبرا متواترا
فأما إذا لم يقبلوا خبر الواحد وقبلوا خبر الأثنين فلا وقد قبلوا خبر الاثنين فيه فلم ينفعكم ذلك
وعن الثاني
أن ذلك يجب أن لو كان يتضمن علما أو أوجب العمل به على كل حال
فأما إذا أوجبه بشرط أن يبلغه فليس فيه تكليف ما لا طريق إليه ولو وجب ذلك فيما تعم به البلوي لوجب في غيره لجواز أن لا يصل إلى من كلف به
فإن قلتم هناك إنه كلف العمل به بشرط أن يبلغه قيل لكم مثله فيما تعم به البلوي
القسم الثالث في الإخبار
وفيه مسائلالمسألة الأولى
في كيفية ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
وهي على سبع مراتب
المرتبة الأولى
أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كذا أو أخبرني رسول الله أو حدثني رسول الله أو شافهني رسول الله صلى الله عليه و سلم
المرتبة الثانية
أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا فهذا ظاهره النقل إذا صدر عن الصحابي وليس نصا صريحا إذ قد يقول الواحد منا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتمادا على ما نقل إليه وإن لم يسمعه منه صلى الله عليه و سلم
إما إذا صدر عن غير الصحابي فليس ظاهره ذلك
المرتبة الثالثة
أن يقول أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا وهذا يتطرق إليه الاحتمال الأول مع احتمال اخر وهو أن مذاهب الناس في صيغ الأوامر النواهي مشهورة فربما ظن ما ليس بأمر أمرا ولأجله اختلف الناس في أنه هل هو حجة أم لا
والأكثرون على أنه حجة لأن الظاهر من حال الراوي أن لا يطلق هذا اللفظ إلا إذا تيقن مراد الرسول صلى الله عليه و سلم
ولقائل أن يقول لم لا يكفي فيه الظن
فإن قلت لأن هذه الصيغة حجة فلو أطلقه الراوي مع تجويزه خلافه لكان قد أوجب على الناس ما يجوز أن لا يكون واجبا عليهم وذلك يقدح في عدالته
فنقول على هذا لا يمكنكم العلم بأن هذا الراوي ما اطلق هذه اللفظه إلا بعد علمه بمراد الرسول إلا إذا علمتم أنه حجة وأنتم إنما اثبتم كونه حجة بذلك فلزم الدور
وفي المسألة احتمال ثالث وهو أن قول الراوي أمر الرسول بكذا ليس فيه لفظ يدل على انه أمر الكل أو البعض دائما أو غير دائم فلا يجوز الاستدلال به إلا إذا ضم إليه قوله عليه الصلاة و السلام حكمي على الواحد حكمي على الجماعة
المرتبة الرابعة
أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو أوجب كذا ونهينا عن كذا وأبيح كذا
قال الشافعي رضي الله عنه إنه يفيد أن الآمر هو الرسول عليه الصلاة و السلام
والكرخي خالف فيه
لنا وجهان
الأول
أن من التزم طاعة رئيس فإنه متى قال أمرنا بكذا فهم منه أمر ذلك الرئيس ألا ترى أن الرجل من خدم السلطان إذا قال في دار السلطان أمرنا بكذا فهم كل أحد من كلامه أمر السلطان
الثاني
أن غرض الصحابي أن يعلمنا الشرع فيجب حمله على من صدر الشرع عنه دون الأئمة دون والولاة فلا يحمل هذ القول على
أمر الله تعالى لأن أمره تعالى ظاهر للكل لا نستفيده من قول الصحابي ولا على أمر جماعة الأمة لأن ذلك الصحابي من الأمة وهو لا يأمر نفسه
المرتبة الخامسة
أن يقول الصحابي من السنة كذا فهم منه سنة الرسول عليه الصلاة و السلام للوجهين المذكورين
فإن قلت هذا غير واجب للخبر والعقل
أما الخبر فقوله عليه الصلاة و السلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وعنى به سنة غيره
وأما العقل فهو أن السنة مأخوذة من الاستنان وذلك غير مختص بشخص دون شخص
قلت لا يمتنع ما ذكرتموه بحسب اللغة ولكن بحسب الشرع يفيد ما قلنا
المرتبة السادسة
أن يقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال قوم يحتمل أن يقال إنه أخبره إنسان آخر عن الرسول صلى الله عليه و سلم وهو لم يسمعه منه
وقال اخرون بل الأظهر أنه سمعه منه
المرتبة السابعة قوله الصحابي كنا نفعل كذا فالظاهر أنه قصد أن يعلمنا بهذا الكلام شرعا ولن يكون كذلك إلا وقد كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه و سلم مع علمه بذلك ومع أنه صلى الله عليه و سلم ما كان ينكر ذلك عليهم وهذا يقتضي كونه شرعا عاما
فأما إذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه فحسن الظن به يقتضي أن يكون قاله عن طريق فإذا لم يمكن الاجتهاد فليس إلا السماع من النبي صلى الله عليه و سلم
المسألة الثانية
في كيفية رواية غير الصحابي
وهذا أيضا على سبع مراتب
المرتبة الأولى
أن يقول الراوي حدثني فلان أو أخبرني فلان أو سمعت فلانا فالسامع يلزمه العمل بهذا الخبر
وأما أن السامع كيف يروي فنقول إن الراوي إن قصد إسماعه خاصة ذلك الكلام أو كان هو في جمع قصد الراوي إسماعهم فله أن يقول ها هنا أخبرني وسمعته يحدث عن فلان
إما أن لم يقصد إسماعه لا على التفصيل ولا على الجملة فله أن يقول سمعته يحدث عن فلان لكن ليس له أن يقول أخبرني ولا حدثني لأنه لم يخبره ولم يحدثه
المرتبة الثانية
أن يقال للراوي هل سمعت هذا الحديث عن فلان فيقول نعم أو يقول بعد الفراغ من القراءة عليه الأمر كما قرىء على فها هنا العمل بالخبر لازم على السامع
وله أيضا أن يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت فلانا ألا ترى أنه لا فرق في الشهادة على البيع بين أن يقول البائع وبين أن يقرأ عليه كتاب البيع فيقول الأمر كما قريء علي
المرتبة الثالثة
أن يكتب إلى غيره بأني سمعت كذا من فلان فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابه إذا علم أنه كتابه واذا ظن أنه خطه جاز له ذلك أيضا لكن ليس له أن يقول سمعت أو حدثني لأنه ما سمع ولا حدث بل يجوز أن يقول أخبرني لأن من كتب إلى غيره كتابا يعرفه فيه واقعة جاز له أن يقول أخبرني
المرتبة الرابعة
أن يقال له هل سمعت هذا الخبر فيشير برأسه أو بأصبعه فالإشارة ها هنا كالعبارة في وجوب العمل
ولا يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني أو سمعته لأنه ما سمع شيئا
المرتبة الخامسة
أن يقرأ عليه حدثك فلان فلا ينكر ولا يقر بعبارة ولا بإشارة فها هنا إن غلب على الظن أنه ما سكت إلا لأن الأمر كما قريء عليه وإلا كان ينكره لزم السامع العمل به لأنه حصل ظن أنه قول الرسول عليه الصلاة و السلام والعمل بالظن واجب
واختلفوا في جواز الرواية فعامة الفقهاء والمحدثين جوزوه والمتكلمون أنكروه
وقال بعض أصحاب الحديث ليس له إلا أن يقول أخبرني قراءة عليه
وكذا الخلاف فيما لو قال القارىء للراوي بعد قراءة الحديث عليه أرويه عنك فقال نعم
فالمتكلمون قالوا لا تجوز له الرواية عنه ها هنا أيضا
حجة الفقهاء
أن الإخبار في أصل اللغة لإفادة الخبر والعلم وهذا السكوت قد أفاد العلم بأن هذا المسموع كلام الرسول عليه الصلاة و السلام فوجب أن يكون إخبارا
وأيضا فلا نزاع في أن لكل قوم من العلماء اصطلاحات مخصوصة يستعملونها في معان مخصوصة إما لأنهم نقلوها بحسب عرفهم إلى تلك المعاني
أو لأنهم استعملوها فيها على سبيل التجوز ثم صار المجاز شائعا والحقيقة مغلوبة ولفظ أخبرني وحدثني ها هنا كذلك لأن هذا السكوت شابه الإخبار في إفادة الظن والمشابهة إحدى أسباب المجاز
وإذا كان هذا الاستعمال مجازا ثم استقر عرف المحدثين عليه صار ذلك كالاسم المنقول بعرف المحدثين أو كالمجاز الغالب وإذا ثبت ذلك وجب جواز استعماله قياسا على سائر الاصطلاحات
حجة المتكلمين
أنه لم يسمع من الراوي شيئا فقوله حدثني وأخبرني وسمعت كذب
و الجواب
ما تقدم من أنه بعد هذا النقل العرفي لا نسلم أنه كذب
المرتبة السادسة
المناولة وهي أن يشير الشيخ إلى كتاب يعرف ما فيه فيقول قد سمعت ما في هذا الكتاب فإنه يكون بذلك محدثا ويكون لغيره أن يروي عنه سواء قال له أروه عني أو لم يقل له ذلك
فأما إذا قال له حدث عني ما في هذا الجزء ولم يقل له قد سمعته فإنه لا يكون محدثا له وإنما جاز
التحدث له وليس له أن يحدث به عنه لأنه يكون كاذبا
وإذا سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك الكتاب ويقول سمعت هذا لأن النسخ تختلف إلا أن يعلم أنهما متفقتان
المرتبة السابعة
الإجازة وهي أن يقول الشيخ لغيره قد أجزت لك أن تروي ما صح عني من أحاديثي
واعلم أن ظاهر الإجازة يقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث بما لم يحدثه به وذلك إباحة الكذب لكنه في العرف يجري مجرى أن يقول ما صح عندك أني سمعته فاروه عني
المسألة الثالثة
ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن المرسل غير مقبول وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور المعتزلة إنه مقبول
لنا
أن عدالة الأصل غير معلومة فلا تكون روايته مقبولة
إنما قلنا إن عدالة الأصل غير معلومة لأنه لم توجد إلا رواية الفرع عنه ورواية الفرع عنه لا تكون تعديلا له إذا المعدل قد يروي عمن لو سئل عنه لتوقف فيه او لجرحه
وبتقدير أن يكون تعديلا لا يقتضى كونه عدلا في نفسه
لاحتمال أنه لو عينه لنا لعرفناه بفسق لم يطلع عليه المعدل فثبت أن عدالته غير معلومة
وإذا كان كذلك وجب أن لا تقبل روايته لأن قبول روايته يقتضي وضع شرع عام في حق كل المكلفين من غير رضاهم وذلك ضرر والضرر على خلاف الدليل ترك العمل به فيما إذا علمت عدالة الراوي فيبقى في الباقي على الأصل
فإن قيل لا نسلم أن عدالته غير معلومة
قوله لم يوجد إلا رواية الفرع عنه ورواية الفرع عنه لا تكون تعديلا له لأنه قد يروي عن العدل وغيره
قلنا لا نزاع في جوازه في الجملة لكن لم لا يجوز أن يقال روايته عن العدل أرجح من روايته عن غيره
وبيانه من وجهين
الأول
أن الفرع مع عدالته لا يجترىء أن يخبر عن الرسول صلى الله عليه و سلم إلا وله الإخبار بذلك ولا يكون له ذلك إلا وهو عالم أو ظان بكونه قولا للرسول صلى الله عليه و سلم
لأنه لو استوى الطرفان لحرم الإخبار ولا يكون عالما ولا ظانا بكونه قولا للرسول إلا إذا علم أو ظن عدالة الأصل
الثاني
أن الفرع مع عدالته ليس له أن يوجب شيئا على غيره أو يطرحه عنه إلا اذا علم أنه عليه الصلاة و السلام أوجب ذلك أو ظنه
فثبت بهذين الدليلين رجحان هذا الاحتمال وهذا يقتضي كون الأصل عدلا ظاهرا فوجب قبول روايته كما في سائر العدول وهذه هي النكتة التي عولوا عليها في وجوب قبول المرسل
ثم ما ذكرتموه من الدليل معارض بالنص والإجماع والقياس
أما النص فعموم قوله تعالى ولينذروا قومهم وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
فإذا جاء من لا يكون فاسقا وجب القبول والراوي للفرع ليس بفاسق فوجب قبول خبره
وأما الإجماع فإن البراء بن عازب قال ليس كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه و سلم سمعناه منه غير أنا لا نكذب
وروى أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة و السلام من أصبح جنبا فلا صوم له ثم ذكر أنه أخبره به الفضل بن عباس
وروى ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال لا ربا إلا في النسيئة ثم اسنده إلى أسامة
وروى أيضا ما زال رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة ثم ذكر أنه أخبره به الفضل بن عباس رضي الله عنهما
وهذه الروايات تدل على جواز قبول المرسل
وأما القياس فلأنه لو لم يقبل المرسل لما قبل ما يجوز كونه مرسلا فكان ينبغي إذا قال الراوي عن فلان أن
لا يقبل لأنه لا يجوز أن يكون أخبر عنه
والجواب
قد بينا أن العدل يروي عن العدل وعن من لا يكون عدلا
قوله لم لا يجوز أن يقال روايته عن العدل أرجح من روايته عمن ليس بعدل
قلنا لأنه إذا ثبت أنه لا منافاة بين كونه عدلا وبين روايته عمن ليس بعدل كان ذلك ممكنا بالنسبة إليه من حيث هو هو والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح منفصل فقبل حصول ذلك المرجح لا يبقى إلا أصل الإمكان
قوله أولا الفرع مع عدالته أخبر عن الرسول ولا يجوز له ذلك الإخبار إلا وقد اعتقد عدالة الراوي
قلنا الفرع إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فهذا يقتضي الجزم بأن هذا القول قول رسول الله والجزم بالشيء مع تجويز نقيضه كذب وذلك يقدح في عدالة الراوي
فإذن لا بد من صرف هذا اللفظ عن ظاهره فليسوا بأن يقولوا المراد منه أني أظن أنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى من أن نقول نحن المراد منه أني سمعت أنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعلوم أنه لو صرح بهذا القدر لم يكن فيه تعديل للأصل لأنه لو سمعه من كافر متظاهر بالكفر لحل أن يقول سمعت أنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فعلمنا سقوط ما ذكروه
قوله ثانيا الفرع مع عدالته ليس يجوز له أن يوجب شيئا على غيره إلا اذا علم أو ظن أنه عليه الصلاة و السلام أوجبه
قلنا روايته إنما توجب على الغير شيئا لو ثبت كون الراوي عدلا فإن بينتم إثبات كونه عدلا بأن هذه الرواية توجب على غيره شيئا لزم الدور
ثم نقول ينتقض ما ذكرتموه من الوجهين بشاهد الفرع إذا لم يذكر شاهد الأصل فإن ما ذكرتموه قائم فيه مع لا تقبل شهادته
فإن قلت الفرق من وجهين
الأول
أن الشهادة تتضمن إثبات حق على عين والخبر يتضمن إثبات الحق على الجملة من دون تخصيص ويدخل من التهمة في إثبات الحقوق على الأعيان ما لا يدخل في إثباتها على الجملة فجاز ان تؤكد الشهادة بما لا تؤكد به الرواية كما أكدنا باعتبار العدد فيها دون الرواية
الثاني
أن شهود الأصل لو رجعوا عن شهادتهم لزمهم الضمان على قول بعض الفقهاء فإذا لم يؤمن أن يؤدي اجتهاد الحاكم إلى ذلك لو رجعوا وجب أن يعرفهم بأعيانهم ليتأتى إلزامهم الضمان إن هم رجعوا
قلت الجواب عن الأول
أن إثبات الحق على الأعيان لو ترجح على إثبات الحق في الجملة من ذلك الوجه فهذا يترجح على ذلك من وجه اخر وهو أن الخبر يقتضي شرعا عاما في حق جميع المكلفين إلى يوم القيامة فالاحتياط فيه أولى من الاحتياط في إثبات الحكم في حق مكلف واحد
وعن الثاني
أنه ملغي بما إذا كان شاهد الأصل قد مات ولم يبق له في الدنيا دينار ولا درهم فكيف يمكن تضمينه
وأما المعارضة الأولى فجوابها
أن هذه النصوص خصصت في الشهادة فوجب تخصيصها في الرواية والجامع الاحتياط
وعن الثانية أن هذه المسألة عندنا اجتهادية فلعل بعض الصحابة كان قائلا به ومخالفوهم ما أنكروه عليهم لكون المسألة اجتهادية
وأيضا فالصحابي الذي رأى الرسول إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كان الظاهر منه الإسناد
وإذا كان كذلك وجب على السامع قبوله ثم بعد ذلك إذا بين الصحابي أنه كان مرسلا ثم بين إسناده وجب أيضا قبوله ولم يكن قبوله في إحدى الحالتين دليلا على العمل بالمرسل
وعن الثالث أن مدار العمل بهذه الأخبار على الظن فإذا قال الراوي قال فلان عن فلان وقد أطال صحبته كان ذلك دليلا على أنه سمعه منه ومتى لم يعلم أنه صحبه كان ذلك دليلا على أنه سمعه منه ومتى لم يعلم أنه صحبه لم يقبل حديثه
فروع
الأول
قال الشافعي رضي الله عنه لا اقبل المرسل إلا إذا كان