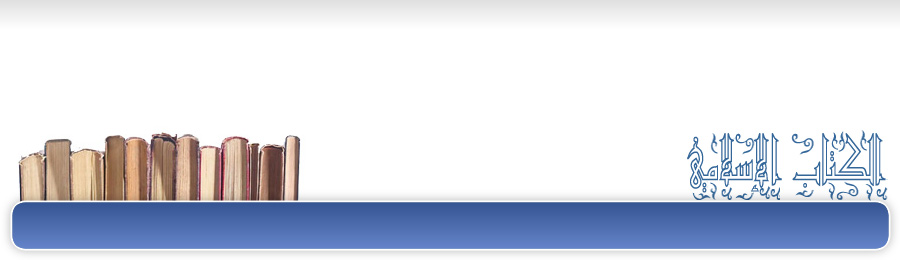كتاب : الإحكام في أصول القرآن
المؤلف : ابن حزم
والحق في ذلك أن يقال: الخاص قد يطلق باعتبارين: الأول وهو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه كأسماء الأعلام من زيد وعمرو ونحوه الثاني ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه وحده أنه اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة كلفظ الإنسان فإنه خاص ويقال على مدلوله وعلى غيره كالفرس والحمار لفظ الحيوان من جهة واحدة.
وإذا تحقق معنى العام والخاص فاعلم أن اللفظ الدال ينقسم إلى عام لا أعم منه كالمذكور فإنه يتناول الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول وإلى خاص لا أخص منه كأسماء الأعلام وإلى ما هو عام بالنسبة وخاص بالنسبة كلفظ الحيوان فإنه عام بالنسبة إلى ما تحته من الإنسان والفرس وخاص بالنسبة إلى ما فوقه كلفظ الجوهر والجسم وأما صيغ العموم عند القائلين بها فهي: إما أن تكون عامة فيمن يعقل وما لا يعقل جمعاً وأفراداً مثل أي في الجزاء والاستفهام وأسماء الجموع المعرفة إذا لم يكن عهد سواء كان جمع سلامة أو جمع تكسير كالمسلمين والرجال والمنكرة كرجال ومسلمين والأسماء المؤكدة لها مثل كل وجميع واسم الجنس إذا دخله الألف واللام من غير عهد كالرجل والدرهم والنكرة المنفية كقولك لا رجل في الدار وما في الدار من رجل والإضافة كقولك ضربت عبيدي وأنفقت دراهمي.
وإما عامة فيمن يعقل دون غيره كمن في الجزاء والاستفهام تقول من عندك ومن جاءني أكرمته.
وإما عامة فيما لا يعقل إما مطلقاً من غير اختصاص بجنس مثل ما في الجزاء كقوله: على اليد ما أخذت حتى ترد والاستفهام تقول ماذا صنعت؟ وإما لا مطلقاً بل مختصة ببعض أجناس ما لا يعقل مثل متى في الزمان جزاء واستفهاماً وأين وحيث في المكان جزاء واستفهاماً تقول: متى جاء القوم ومتى جئتني أكرمتك وأين كنت وأينما كنت أكرمتك.
وإذ أتينا على ما أردناه من بيان المقدمة فلنشرع الآن في المسائل وهي خمس وعشرون مسألة.
المسألة الأولى اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة واختلفوا في عروضه حقيقة للمعاني: فنفاه الجمهور وأثبته الأقلون.
وقد احتج المثبتون بقولهم: الإطلاق شائع ذائع في لسان أهل اللغة بقولهم: عم الملك الناس بالعطاء والإنعام وعمهم المطر والخصب والخير وعمهم القحط وهذه الأمور من المعاني لا من الألفاظ والأصل في الإطلاق الحقيقة.
أجاب النافون بأن الإطلاق في مثل هذه المعاني مجاز لوجهين: الأول: أنه لو كان حقيقة في المعاني لاطرد في كل معنى إذ هو لازم الحقيقة وهو غير مطرد ولهذا فإنه لا يوصف شيء من الخاصة الواقعة في امتداد الإشارة إليها كزيد وعمرو بكونه عاماً لا حقيقة ولا مجازاً.
الثاني: أن من لوازم العام أن يكون متحداً ومع اتحاده متناولاً لأمور متعددة من جهة واحدة والعطاء والإنعام الخاص بكل واحد من الناس غير الخاص بالآخر وكذلك المطر فإن كل جزء اختص منه بجزء من الأرض لا وجود له بالنسبة إلى الجزء الآخر منها وكذلك الكلام في الخصب والقحط فلم يوجد من ذلك ما هو مع اتحاده يتناول أشياء من جهة واحدة فلم يكن عاماً حقيقة بخلاف اللفظ الواحد كلفظ الإنسان والفرس.
أجاب المثبتون عن الأول بأن العموم وإن لم يكن مطرداً في كل معنى فهو غير مطرد في كل لفظ فإن أسماء الأعلام كزيد وعمرو ونحوه لا يتصور عروض العموم لها لا حقيقة ولا مجازاً فإن كان عدم اطراده في المعاني مما يبطل عروضه للمعاني حقيقة فكذلك في الألفاظ وإن كان ذلك لا يمنع في الألفاظ فكذلك في المعاني ضرورة عدم الفرق.
وعن الوجه الثاني أنه: وإن تعذر عروض العموم للمعاني الجزئية الواقعة في امتداد الإشارة إليها حقيقة فليس في ذلك ما يدل على امتناع عروضه للمعاني الكلية المتصورة في الأذهان كالمتصور من معنى الإنسان المجرد عن الأمور الموجبة لتشخيصه وتعيينه فإنه مع اتحاده فمطابق لمعناه وطبيعته لمعاني الجزئيات الداخلة تحته من زيد وعمرو من جهة واحدة كمطابقة اللفظ الواحد العام لمدلولاته وإذا كان عروض العموم للفظ حقيقة إنما كان لمطابقته مع اتحاده للمعاني الداخلة تحته من جهة واحدة فهذا المعنى بعينه متحقق في المعاني الكلية بالنسبة إلى جزئياتها فكان العموم من عوارضها حقيقة.
المسألة الثانية
اختلف العلماء في معنى العموم: هل له في اللغة صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه أم لا؟ فذهبت المرجئة إلى أن العموم لا صيغة له في لغة العرب وذهب الشافعي وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء إلى أن ما سبق ذكره من الصيغ حقيقة في العموم مجاز فيما عداه ومنهم من خالف في الجميع المنكر والمعروف واسم الجنس إذا دخله الألف واللام كما يأتي تعريفه وهو مذهب أبي هاشم وذهب أرباب الخصوص إلى أن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص ومجاز فيما عداه وقد نقل عن الأشعري قولان: أحدهما القول بالاشتراك بين العموم والخصوص والآخر الوقف وهو عدم الحكم بشيء مما قيل في الحقيقة في العموم أو الخصوص أو الاشتراك ووافقه على الوقف القاضي أبو بكر وعلى كل واحد من القولين جماعة من الأصوليين ومن الواقفية من فصل بين الإخبار والوعد والوعيد والأمر والنهي فقال بالوقف في الإخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي.
والمختار إنما هو صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص لكونه مراداً من اللفظ يقيناً سواء أريد به الكل أو البعض والوقف فيما زاد على ذلك ومنهاج الكلام فعلى ما عرف في التوقف في الأمر بين الوجوب والندب فعليك بنقله إلى هاهنا وإنما يتحقق هذا المقصود بذكر شبه المخالفين والانفصال عنها.
ولنبدأ من ذلك بشبه أرباب العموم وهي نصية وإجماعية ومعنوية.
أما النصية فمنها قول الله تعالى: " ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق " " هود 45 " تمسكاً منه بقوله تعالى: " إنا منجوك وأهلك " " العنكبوت 33 " وأقره الباري تعالى على ذلك وأجابه بما دل على أنه ليس من أهله ولولا أن إضافة الأهل إلى نوح للعموم لما صح ذلك ومنها أنه لما نزل قوله تعالى: " إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم " " الأنبياء 98 " قال ابن الزبعري: لأخصمن محمداً ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: " وقد عبدت الملائكة والمسيح أفتراهم يدخلون النار " واستدل بعموم ما ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل نزل قوله تعالى غير منكر لقوله بل مخصصاً له بقوله تعالى: " إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون " " الأنبياء 101 " ومنها قوله تعالى: " ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال: إن فيها لوطاً قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين " " العنكبوت 31 - 32 " ووجه الاحتجاج بذلك أن إبراهيم فهم من أهل هذه القرية العموم حيث ذكر لوطاً والملائكة أقروه على ذلك وأجابوه بتخصيص لوط وأهله بالاستثناء واستثناء امرأته من الناجين وذلك كله يدل على العموم.
وأما الإجماعية فمنها احتجاج عمر على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله: كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم " ولم ينكر عليه أحد من الصحابة احتجاجه بذلك بل عدل أبو بكر إلى التعليق بالاستثناء وهو قوله صلى الله عليه وسلم " إلا بحقها " فدل على أن لفظ الجمع المعرف للعموم ومنها احتجاج فاطمة على أبي بكر في توريثها من أبيها فدك والعوالي بقوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " " النساء 11 " ولم ينكر عليها أحد من الصحابة بل عدل أبو بكر رضي الله عنه إلى ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى دليل التخصيص وهو قوله عليه السلام: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " ومنها احتجاج عثمان على علي رضي الله عنه في جواز الجمع بين الأختين بقوله تعالى: " إلا على أزواجهم " " المعارج 30 " واحتجاج علي بقوله تعالى: " وأن تجمعوا بين الأختين " " النساء 23 " ولم ينكر على أحد منهما صحة ما احتج به وإنما يصح ذلك أن لو كانت الأزواج المضافة والأختان على العموم ومنها أن عثمان لما سمع قول الشاعر:
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل
قال له: كذبت فإن نعيم أهل الجنة لا يزول ولم ينكر عليه منكر ولولا أن كل للعموم لما كان كذلك ومنها احتجاج أبي بكر على الأنصار بقوله صلى الله عليه وسلم " الأئمة من قريش " ووافقه الكل على صحة هذا الاحتجاج من غير نكير ولو لم يكن لفظ الأئمة عاماً لما صح الاحتجاج ومنها إجماع الصحابة على إجراء قوله تعالى " " الزانية والزاني " " النور 2 " " والسارق والسارقة " " المائدة 38 " " ومن قتل مظلوماً " " الإسراء 33 " " وذروا ما بقي من الربا " " البقرة 278 " " ولا تقتلوا أنفسكم " " النساء 29 " " ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " " المائدة 95 " وقوله صلى الله عليه وسلم " لا وصية لوارث " " ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ومن ألقى سلاحه فهو آمن " إلى غير ذلك على العموم.
وأما الشبه المعنوية فمنها أن العموم من الأمور الظاهرة الجلية والحاجة مشتدة إلى معرفته في التخاطب وذلك مما تحيل العادة مع توالي الأعصار على أهل اللغة إهماله وعدم تواضعهم على لفظ يدل عليه مع أنه لا يتقاصر في دعو الحاجة إلى معرفته عن معرفة الواحد والاثنين وسائر الأعداد والخبر والاستخبار والترجي والتمني والنداء وغير ذلك من المعاني التي وضعت لها الأسماء وربما وضعوا لكثير من المسميات ألفاظاً مترادفة مع الاستغناء عنها ومنها ما يخص كل واحد واحد من الألفاظ المذكورة من قبل.
أما من الاستفهامية كقول القائل: من جاءك؟ فلا يخلو إما أن تكون حقيقة في الخصوص أو العموم أو مشتركة بينهما أو موقوفة أو ليست موضوعة لأحد الأمرين لا حقيقة ولا تجوزاً والأول محال وإلا لما حسن أن يجاب بجملة العقلاء لكونه جواباً عن غير ما سأل عنه ولا جائز أن تكون مشتركة أو موقوفة وإلا لما حسن الجواب بشيء إلا بعد الاستفهام عن مراد المسائل وليس كذلك ولا جائز أن يقال بالأخير للاتفاق على إبطاله فلم يبق إلا أن تكون حقيقة في العموم.
وأما الشرطية وهي عندما إذا قال السيد لعبده من دخل داري فأكرمه فإنه إذا أكرم كل داخل لا يحسن من السيد الاعتراض عليه ولو أخل بإكرام بعض الداخلين فإنه يحسن لومه وتوبيخه في العرف وأيضاً فإنه يحسن الاستثناء من ذلك بقوله إلا أن يكون فاسقاً والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لكان داخلاً فيه ولولا أن من للعموم لما صح ذلك.
وعلى هذا يكون الكلام في جميع الحروف المستعملة للشرط والاستفهام مثل: ما وأي ومتى وأين وكم وكيف ونحوه ومؤكداتها مثل: كل وجميع فإنها للعموم وبيانه من وجوه: الأول: أنه إذا قال القائل لعبده أكرم كل من رأيته فإنه يسقط عنه اللوم بإكرام كل واحد ولا يسقط بتقدير إخلاله بإكرام البعض وأنه يحسن الاستثناء بقوله إلا الفساق وذلك دليل العموم كما سبق.
الثاني: أنه لو قال رأيت كل من في البلد فإنه يعد كاذباً بتقدير عدم رؤيته لبعضهم.
الثالث: أنه إذا قال القائل كل الناس علماء كذبه قول القائل كل الناس ليسوا علماء ولو لم يكن اسم كل للعموم لما كان كل واحد مكذباً للآخر لجواز أن يتناول كل واحد غير ما تناوله الآخر.
الرابع: أنا ندرك التفرقة بين كل وبعض ولو كان كل غير مفيد للعموم لما تحقق الفرق لكونه مساوياً في الإفادة للبعض.
الخامس: أنه لو كان قول القائل كل الناس يفيد العموم ولكنه يعبر عنه تارة عن البعض وتارة عن العموم حقيقة لكان قول القائل كلهم بياناً لأحد الأمرين فيما دخل عليه لا تأكيداً له كما لو قال رأيت عيناً باصرة.
وأما الجمع المعرف فهو للعموم لوجهين: الأول: أن كثرة الجمع المعرف تزيد على كثرة الجمع المنكر ولهذا يقال: رجال من الرجال ولا عكس وعند ذلك فالجمع المعرف إما أن يكون مفيداً للاستغراق أو للعدد غير مستغرق لا جائز أن يقال بالثاني لأن ما من عدد يفرض من ذلك إلا ويصح نسبته إلى المعرفة بأنه منه والأول هو المطلوب.
الثاني: أنه يصح تأكيده بما هو مفيد للاستغراق والتأكيد إنما يفيد تقوية المؤكد لا أمراً جديداً فلو لم يكن المؤكد يفيد الاستغراق لما كان المؤكد مفيداً له أو كان مفيداً لأمر جديد وهو ممتنع.
وأما النكرة المنفية كقوله لا رجل في الدار أو في سياق النفي كقوله ما في الدار من رجل فإن القائل لذلك يعد كاذباً بتقدير رؤيته لرجل ما وأنه يحسن الاستثناء بقوله إلا زيد وأنه يصح تكذيبه بأنك رأيت رجلاً كما ورد قوله تعالى: " قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى " " الأنعام 91 " تكذيباً لمن قال: " ما أنزل الله على بشر من شيء " " الأنعام 91 " وكل ذلك يدل على كونها للعموم ولأنها لو لم تكن للعموم لما كان قولنا لا إله إلا الله توحيداً لعدم دلالته على نفي كل إله سوى الله تعالى.
وأما الإضافة كقوله: أعتقت عبيدي وإمائي فإنه يدل على العموم بدليل لزوم العتق في الكل وأنه يجوز لمن سمعه أن يزوج من أي العبيد شاء وأن يتزوج من الإماء من شاء دون رضى الورثة وكذلك لو قال العبيد الذين هم في يدي لفلان صح الإقرار بالنسبة إلى الجميع ولولا أن ذلك للعموم لما كان كذلك.
وأما الجنس إذا دخله الألف واللام ولا عهد فإنه للعموم لأربعة أوجه: الأول: أنه إذا قال القائل رأيت إنساناً أفاد رؤية واحد معين فإذا دخلت عليه الألف واللام فلو لم تكن الألف واللام مفيدة للاستغراق لكانت معطلة لتعذر حملها على تعريف الجنس لكونه معلوماً دونها وهو ممتنع.
الثاني: أنه يصح نعته بالجمع المعرف وقد ثبت أن الجمع المعرف للعموم فكذلك المنعوت به وذلك في قولهم أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض وأنه يصح الاستثناء منه كما في قوله تعالى: " إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا " " العصر 2 - 3 " وهو دليل العموم.
الثالث: أن القائل قائلان: قائل يقول إن الألف واللام الداخلة على الاسم المفرد والجمع تفيد العموم وقائل بالنفي مطلقاً وقد ثبت أنها مفيدة للعموم في الجمع فالتفرقة تكون قولاً بتفصيل لم يقل به قائل.
الرابع: أنه إذا كانت الألف واللام لتعريف المعهود عائدة إلى جميعه لعدم أولوية عودها إلى البعض منه دون البعض فكذلك إذا كانت لتعريف الجنس.
وأما الجمع المنكر فيدل على أنه للعموم ثلاثة أوجه: الأول: أن قول القائل: رجال يطلق على كل جمع على الحقيقة حتى الجمع المستغرق فإذا حمل الاستغراق كان حملاً له على جميع حقائقه فكان أولى.
الثاني: أنه لو أراد المتكلم بلفظ الجمع المنكر البعض لعينه وإلا كان مراده مبهماً فحيث لم يعينه دل على أنه للاستغراق.
الثالث: أنه يصح دخول الاستثناء عليه بكل واحد من آحاد الجنس فكان للعموم.
ومن شبههم أن العرب فرقت بين تأكيد العموم والخصوص في أصل الوضع فقالوا في الخصوص رأيت زيداً عينه نفسه ولا يقولون رأيت زيداً كلهم أجمعين وقالوا في العموم رأيت الرجال كلهم أجمعين ولا يقولون رأيت الرجال عينه نفسه واختلاف التأكيد يدل على اختلاف المؤكد لأن التأكيد مطابق للمؤكد.
ومنها أنهم قالوا: وقع الإجماع على أن الباري تعالى قد كلفنا أحكاماً تعم جميع المكلفين فلو لم يكن للعموم صيغة تفيده لما وقع التكليف به لعدم ما يدل عليه أو كان التكليف به تكليفاً بما لا يطاق وهو محال.
وأما شبه أرباب الخصوص فأولها: أن تناول اللفظ للخصوص متيقن وتناوله للعموم محتمل فجعله حقيقة في المتيقن أولى.
وثانيها: أن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص دون العموم ومنه يقال: جمع السلطان التجار والصناع وكل صاحب حرفة وأنفقت دراهمي وصرمت نخيلي ونحوه فكان جعلها حقيقة فيما استعمالها فيه أغلب أولى.
وثالثها: أنه إذا قال السيد لعبده أكرم الرجال ومن دخل داري فأعطه درهماً ومتى جاءك فقير فتصدق عليه ومتى جاء زيد فأكرمه وأين كان وحيث حل فإنه لا يحسن الاستفسار عن إرادة البعض ويحسن الاستفسار عما وراء ذلك فكان جعل هذه الصيغ حقيقة فيما لا يحسن الاستفسار عنه دون ما يحسن.
ورابعها: أنه لو كان قول القائل رأيت الرجال للعموم لكان إذا أريد به الخصوص كان المخبر كاذباً كما لو قال رأيت عشرين ولم ير غير عشرة بخلاف ما إذا كانت للخصوص وأريد به العموم.
وخامسها: لو كانت للعموم لكان تأكيدها غير مفيد لغير ما أفادته فكان عبثاً وكان الاستثناء منها نقضاً.
وسادسها: ويخص من أنها لو كانت للعموم لما جمعت لأن الجمع لا بد وأن يفيد ما لا يفيده المجموع وليس بعد العموم والاستغراق كثرة فلا يجمع وقد جمعت في باب حكاية النكرات عند الاستفهام فإنه إذا قال القائل جاءني رجال قلت: منون؟ في حالة الوقف دون الوصل ومنه قول الشاعر:
أتوا ناري فقلت: منون أنتم؟ ... فقالوا: الجن قلت: عموا ظلاماً
فقد قال سيبويه: أنه شاذ غير معمول به.
وأما شبه أرباب الاشتراك فأولها أن هذه الألفاظ والصيغ قد تطلق للعموم تارة وللخصوص تارة والأصل في الإطلاق الحقيقة وحقيقة الخصوص غير حقيقة العموم فكان اللفظ المتحد الدال عليهما حقيقة مشتركا كلفظ العين والقرء ونحوه.
وثانيها: أنه يحسن عند إطلاق هذه الصيغ الاستفهام من مطلقها أنك أردت البعض أو الكل وحسن الاستفهام عن كل واحد منهما دليل الاشتراك فإنه لو كان حقيقة في أحد الأمرين دون الآخر لما حسن الاستفهام عن جهة الحقيقة.
وأما شبه من قال بالتعميم في الأوامر والنواهي دون الأخبار فهو أن الإجماع منعقد على التكاليف بأوامر عامة لجميع المكلفين وبنواه عامة لهم فلو لم يكن الأمر والنهي للعموم لما كان التكليف عاماً أو كان تكليفاً بما لا يطاق وهو محال وهذا بخلاف الإخبار فإنه ليس بتكليف ولأن الخبر يجوز وروده بالمجهول ولا بيان له أصلاً كقوله تعالى: " وكم أهلكنا قبلهم من قرن " " مريم 74 " " وقروناً بين ذلك كثير " " الفرقان 38 " بخلاف الأمر فإنه وإن ورد بالمجمل كقوله: " وآتوا حقه يوم حصاده " " الأنعام 141 " وقوله " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " " النور 56 " فإنه لا يخلو عن بيان متقدم أو متأخر أو مقارن.
والجواب من جهة الإجمال عن جملة هذه الشبه ما أسلفناه في مسألة أن الأمر للوجوب أو الندب فعليك بنقله إلى هاهنا.
وأما من جهة التفصيل أما ما ذكره أرباب العموم من الآيات أما قصة نوح فلا حجة فيها وذلك لأن إضافة الأهل قد تطلق تارة للعموم وتارة للخصوص كما في قولهم جمع السلطان أهل البلد وإن كان لم يجمع النساء والصبيان والمرضى وعند ذلك فليس القول بحمل ذلك على الخصوص بقرينة أولى من القول بحمله على العموم بقرينة ونحن لا ننكر صحة الحمل على العموم بالقرينة وإنما الخلاف في كونه حقيقة أم لا.
وأما قصة ابن الزبعري فلا حجة فيها أيضاً لأن سؤاله وقع فاسداً حيث ظن أن ما عامة فيمن يعقل وليس كذلك ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم منكراً عليه ما أجهلك بلغة قومك أما علمت أن ما لما لا يعقل وهي وإن أطلقت على من يعقل كما في قوله تعالى " والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها " " الشمس 5 - 6 - 7 - 8 " فليس حقيقة بل مجازاً ويجب القول بذلك جمعاً بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم " أما علمت أن ما لما لا يعقل " ولما فيه من موافقة المنقول عن أهل اللغة في ذلك وأما قصة إبراهيم فجوابها بما سبق في قصة نوح.
وأما الاحتجاج بقصة عمر مع أبي بكر فلا حجة فيها أيضاً لأنه إنما فهم العصمة من العلة الموجبة لها في الأموال والدماء وهي قول لا إله إلا الله فإنها مناسبة لذلك والحكم مرتب عليها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك إيماء إليها بالتعليل أما أن يكون ذلك مأخوذاً من عموم دمائهم وأموالهم فلا ومعارضة أبي بكر إنما كانت لما فهمه عمر من التعليل المقتضي للتعميم لا لغيره.
وأما قصة فاطمة مع أبي بكر فالكلام في اعتقاد العموم في قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم " " النساء 11 " ما سبق في قصة نوح وهو الجواب أيضاً عن احتجاج عثمان على جواز الجمع بين الأختين ثم قد أمكن أن يضاف ذلك إلى ما فهم من العلة الموجبة لرفع الحرج وهي الزوجية لا إلى عموم اللفظ وكذلك احتجاج علي بقوله: " وأن تجمعوا بين الأختين " " النساء 23 " لم يكن لعموم اللفظ بل بما أومى إليه اللفظ من العلة المانعة من الجمع وهي الأخوة فإنها مناسبة لذلك دفعاً للإضرار الواقع بين الأختين من المزاحمة على الزوج الواحد وإنما يصح الاحتجاج باللفظ بمجرده إن لو كان للعموم وهو محل النزاع وإن صح الاحتجاج في هذه الصور بنفس اللفظ فلا يمتنع أن يكون ذلك بما اقترن به من قرينة العلة الرافعة للحرج في احتجاج عثمان والعلة المانعة من الجمع في احتجاج علي رضي الله عنه.
وأما تكذيب عثمان للشاعر في قوله " وكل نعيم لا محالة زائل " فإنما كان لما فهمه من قرينة حال الشاعر الدالة على قصد تعظيم الرب ببقائه وبطلان كل ما سواه أما أن يكون ذلك مستفاداً من ذلك مستفاداً من مجرد قوله كل فلا.
وأما استدلال أبي بكر بقوله صلى الله عليه وسلم: " الأئمة من قريش " إنما فهم منه التعميم لما ظهر له من قصد النبي صلى الله عليه وسلم لتعظيم قريش وميزتهم على غيرهم من القبائل فلو لم يكن ذلك يدل على الخصوص فيهم والاستغراق لما حصلت هذه الفائدة.
وأما إجماع الصحابة على إجراء ما ذكروه من الآيات والأخبار على التعميم في كل سارق وزان وغير ذلك فإنما كان ذلك بناء على ما اقترن بها من العلل المومى إليها الموجبة للتعميم وهي السرقة والزنا وقتل الظالم إلى غير ذلك أما أن يكون اعتقاد تعميم تلك الأحكام مستنداً إلى عموم تلك الألفاظ فلا.
وأما ما ذكر من الشبهة الأولى المعنوية فالجواب عنها: أنا وإن سلمنا أن العموم ظاهر وأن الحاجة داعية إلى وضع لفظ يدل عليه ولكن لا نسلم إحالة الإخلال به على الواضعين ولهذا قد أخلوا بالألفاظ الدالة على كثير من المعاني الظاهرة التي تدعو الحاجة إلى تعريفها بوضع اللفظ عليها وذلك كالفعل الحالي ورائحة المسك والعود وغير ذلك من أنواع الروائح والطعوم الخاصة بمحالها.
فإن قيل: لا نسلم أنهم أخلوا بشيء من ذلك فإنهم يقولون: رائحة المسك ورائحة العود وطعم العسل وطعم السكر إلى غير ذلك والإضافة من جملة الأوضاع المعرفة ولهذا فإن الباري تعالى قد عرف نفسه بالإضافة في قوله " ذو العرش ذو الطول " إلى غير ذلك.
قلنا: وعلى هذا لا نسلم أن العرب أخلت بما يعرف العموم فإن الأسماء المجازية والمشتركة أيضاً من الأسماء المعرفة كما سيأتي بيانه وما وقع فيه الخلاف من ألفاظ العموم فهي غير خارجة في نفس الأمر عن كونها حقيقة في العموم دون غيره أو مجازاً فيه وحقيقة فيه وفي غيره فتكون مشتركة وعلى كل تقدير فما خلا العموم في وضعهم عن معرف ولا خلاف في ذلك وإنما الخلاف في جهة دلالته عليه هل هي حقيقة أو مجاز وخفاء جهة الدلالة والوقوف في تعيينها لا يبطل أصل الوضع والتعريف.
وأما الشبهة الثانية وقولهم إن من إذا كانت استفهامية لا تخلو عن الأقسام المذكورة في نفس الأمر مسلم ولكن لم قالوا بوجوب تعيين بعضها مع عدم الدليل القاطع على ذلك قولهم: لو كانت للخصوص لما حسن الجواب بكل العقلاء.
قلنا: ولو كانت للعموم لما حسن الجواب بالبعض الخاص لما قرروه وليس أحد الأمرين أولى من الآخر كيف وإن الجواب بالكل بتقدير أن يكون للخصوص يكون جواباً عن المسؤول عنه وزيادة والجواب بالخصوص بتقدير أن يكون للعموم لا يكون جواباً عن المسؤول عنه ولذلك كان الجواب بالكل مستحسناً ثم ما المانع أن تكون مشتركة.
قولهم: لأنه لا يحسن الجواب إلا بعد الاستفهام قلنا: إذا كانت مشتركة وهي استفهامية فالاستفهام إنما هو عن مدلولها ومدلولها عند الاستفهام إنما هو أحد المدلولين لا بعينه فإذا أجاب بأحد الأمرين فقد أجاب عما سئل عنه فلا حاجة بالمسؤول إلى الاستفهام.
قولهم في الشرطية إن المفهوم من قول السيد لعبده من دخل داري فأكرمه العموم لما قرروه.
قلنا: ليس ذلك مفهوماً من نفس اللفظ بل من قرينة إكرام الزائر حتى أنا لو قدرنا أنه لا قرينة أصلاً ولا تحقق لما سوى اللفظ المذكور فإنا لا نسلم فهم العموم منه ولا جواز التعميم دون الاستفهام أو ظهور دليل يدل عليه بناء على قولنا بالوقف ويدل على ذلك أنه يحسن الاستفهام من العبد ولو كان على أي صفة قدر وحسن ذلك يدل على الترديد ولولا الترديد لما حسن الاستفهام.
قولهم إنه يحسن الاستثناء منه مسلم ولكن لا نسلم أنه لا بد من دخول ما استثني تحت المستثنى منه فإن الاستثناء من غير الجنس صحيح وإن لم يكن المستثنى داخلاً تحت المستثنى منه ولا له عليه دلالة ويدل على صحة ذلك قوله تعالى: " ما لهم به من علم إلا اتباع الظن " " النساء 157 " والظن هاهنا غير داخل تحت لفظ العلم وقول الشاعر:
وقفت فيها أصيلالا أسائلها ... عيت جواباً وما بالربع من أحد
إلا أواري لأياً ما أبينها ... والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد
فإن قيل: نحن إنما ندعي ذلك فيما كان من الجنس لا في غيره.
قلنا: وإذا كان من الجنس فالاستثناء يدل على وجوب دخول ما استثني تحت المستثنى منه أو على صلاحيته للدخول تحته: الأول ممنوع والثاني مسلم ويدل على ذلك صحة استثناء كل واحد من آحاد الجنس من جموع القلة وهي ما يتناول العشرة فما دونها وهي: أفعل نحو أفلس وأفعال نحو أصنام وأفعلة نحو أرغفة وفعلة نحو صبية مع أن آحاد الجنس غير واجبة الدخول تحت المستثنى منه والاستثناء من جمع السلامة إذا لم تدخله الألف واللام فإنه من جموع القلة بنص سيبويه.
فإن قيل: نحن إنما ندعي ذلك فيما يصح استثناء العدد الكثير والقليل منه واستثناء العدد الكثير وهو ما زاد على العشرة لا يصح من جمع القلة.
قلنا: فيلزم عليه استثناء ما لا يصح من جمع القلة قلنا فيلزم عليه استثناء ما زاد على العشرة من الجمع المنكر فإنه يصح وإن كان كل واحد من المستثنيات غير واجب الدخول تحت الجمع المنكر بل ممكن الدخول.
فإن قيل: لو صح الاستثناء لإخراج ما يصح دخوله لا ما يجب دخوله لصح أن يقول القائل رأيت رجلاً إلا زيداً لصلاحية دخوله تحت لفظ رجل وهو غير صحيح وأيضاً فإن الاستثناء يدخل في الأعداد كقول القائل له علي عشرة دراهم إلا درهماً وهو واجب الدخول وأيضاً فإن أهل اللغة قالوا بأن الاستثناء إخراج جزء من كل والجزء واجب الدخول في كله.
قلنا: أما الأول فلأن قوله رأيت رجلاً لا يكون إلا معيناً في نفس الأمر ضرورة وقوع الرؤية عليه وإن لم يكن معيناً عند المستمع والمعين لا يصح الاستثناء منه إجماعاً.
وأما الثاني فبعيد عن التحقيق من حيث إن وجوب دخول الواحد في العشرة لا يمنع من صحة دخوله فيها بمعنى أنه لا يمتنع دخوله فيها وما ليس بممتنع أعم من الواجب وعند ذلك فلا يلزم أن يكون الاستثناء لوجوب الدخول بل لصحة الدخول وهو الجواب عن الوجه الثالث أيضاً كيف وإن استثناء واجب الدخول لا يمنع من استثناء ممكن الدخول وعلى ما قررناه في إبطال الاستدلال على عموم من استفهامية وجزائية يكون بعينه جواباً عما ذكروه من الوجه الأول في عموم كل وجميع.
قولهم في الوجه الثاني إنه لو قال: رأيت كل من في البلد يعد كاذباً بتقدير عدم رؤية بعضهم لا نسلم لزوم ذلك مطلقاً فإنه لو قال القائل جمع السلطان كل التجار وكل الصناع وجاء كل العسكر فإنه لا يعد في العرف كاذباً بتقدير تخلف آحاد الناس والعرف بذلك شائع ذائع وليس حوالة ذلك على القرينة أولى من حوالة صورة التكذيب على القرينة.
قولهم في الوجه الثالث إن قول القائل: كل الناس علماء يكذبه قول الآخر كل الناس ليس علماء ليس كذلك مطلقاً فإنه لو فسر كلامه بالغالب عنده كان تفسيره صحيحاً مقبولاً ومهما أمكن حمل كلامه على ذلك فلا تكاذب نعم إنما يصح التكاذب بتقدير ظهور الدليل الدال على إرادة الكل بحيث لا يشذ منهم واحد وذلك مما لا ينكر وإنما النزاع في اقتضاء اللفظ لذلك بمطلقه.
قولهم في الوجه الرابع: إنا ندرك التفرقة بين بعض وكل مسلم لكن من جهة أن بعضاً لا يصلح للاستغراق وكلا صالح له ولما دونه ولا يلزم من ذلك ظهور كل في العموم.
قولهم في الوجه الخامس: إنه يلزم أن يكون قوله كلهم بياناً لا تأكيداً قلنا: وإن بين به مراده من لفظه لا يخرجه ذلك عن كونه تأكيداً لما أراده من العموم فإن لفظه صالح له.
قولهم في الجمع المعرف إن كثرة الجمع المعرف تزيد على كثرة المنكر قلنا: متى إذا أريد به الاستغراق أو إذا لم يرد به ذلك الأول مسلم والثاني ممنوع ولا يلزم من كونه صالحاً للاستغراق أن يكون متعيناً له بل غايته أنه إذا قال رأيت رجالاً من الرجال كان ذلك قرينة صارفة للجمع المعرف إلى الاستغراق.
قولهم إنه يصح تأكيده بما يفيد الاستغراق قلنا: ذلك يستدعي كون المؤكد صالحاً للعموم والدلالة على العموم عند التأكيد ولا يدل على كونه بوضعه للعموم.
قولهم في تعميم النكرة المنفية: لو قال لا رجل في الدار فإنه يعد كاذباً بتقدير رؤيته لرجل ما قلنا إنما عد كاذباً بذلك لأن قوله لا رجل في الدار إنما ينفي حقيقة رجل في الدار فإذا وجد رجل في الدار كان كاذباً ولا يلزم من ذلك العموم في طرف النفي إذ هو نفي ما ليس بعام.
قولهم إنه يحسن الاستثناء سبق جوابه قولهم: إنه يصح تكذيبه بأنك رأيت رجلاً قلنا: سبق جوابه أيضاً.
قولهم: لو لم يكن للعموم لما كان قول القائل: لا إله إلا الله توحيداً قلنا: وإن لم يكن حقيقة في العموم فلا يمتنع إرادة العموم بها وعلى هذا فمهما لم يرد المتكلم بها العموم فلا يكون قوله توحيداً وإن أراد ذلك كان توحيداً لكن لا يكون العموم من مقتضيات اللفظ بل من قرينة حال المتكلم الدالة على إرادة التوحيد وعلى هذا يكون الحكم أيضاً فيما إذا قال: ما في الدار من رجل وقول أهل الأدب إنها للعموم يمكن حمله على عموم الصلاحية دون الوجوب.
قولهم في الإضافة إذا قال: أعتقت عبيدي وإمائي ثم مات جاز لمن سمعه أن يزوج من شاء من العبيد دون رضى الورثة قلنا: ولو قال أنفقت دراهمي وصرمت نخيلي وضرب عبيدي فإنه لا يعد كاذباً بتقدير عدم إنفاق بعض دراهمه وعدم صرم بعض نخيله وعدم ضرب بعض عبيده ولو كان ذلك للعموم لكان كاذباً وليس صرف ذلك إلى القرينة أولى من صرف ما ذكروه إلى القرينة وهو الجواب عن قوله العبيد الذين في يدي لفلان وما ذكروه في الدلالة على تعميم اسم الجنس إذا دخله الألف واللام.
أما الوجه الأول منه قولهم إنه لا بد للألف واللام من فائدة قلنا: يمكن أن تكون فائدتها تعريف المعهود وإن لم يكن ثم معهود فالتردد بين العموم والخصوص على السوية بخلاف ما قبل دخولها.
وأما الوجه الثاني: فقد قيل إنه من النقل الشاذ الذي لا اعتماد عليه وهو مع ذلك مجاز ولهذا فإنه لم يطرد في كل اسم فرد فإنه لا يقال جاءني الرجل العلماء والرجل المسلمون ثم وإن أمكن نعته بالجمع فإنما كان كذلك لأن المراد من قولهم إنما هو جنس الدينار وجنس الدرهم لا جملة الدنانير وجملة الدراهم وحيث كان الهلاك بجنس الدينار والدرهم لأمر متحقق في كل واحد من ذلك الجنس جاز نعته بالجمع نظراً إلى اقتضاء المعنى للجمع لا نظراً إلى اقتضاء لفظ الدينار.
وأما الاستثناء في الآية فهو مجاز ولهذا لم يطرد فإنه لا يحسن أن يقال: رأيت الرجل إلا العلماء وعلى هذا النحو ثم لو كان ذلك صالحاً للاستغراق لأمكن مع اتحاده أن يؤكد بكل وجميع كما في من في قولك من دخل داري أكرمته وهو غير جائز فإنه لا يحسن أن يقال: جاءني الرجل كلهم أجمعون ويمكن أن يقال: إن مثل هذا قياس في اللغة وهو غير جائز.
وأما الوجه الثالث: فدفعه بمنع الحصر فيما قيل بل القائل ثلاثة والثالث هو القائل بالتفصيل.
وأما الوجه الرابع: فحاصله يرجع إلى القياس في اللغة وقد أبطلناه وأما ما ذكروه في تعميم الجمع المنكر أما الوجه الأول منه فعنه جوابان: الأول: أن قول القائل رجال حقيقة في كل عدد على خصوصه ممنوع وإن أراد به أنه حقيقة في الجمع المشترك بين جميع الأعداد فمسلم ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون دالاً على ما هو الأخص لا حقيقة ولا مجازاً وعلى هذا فقد بطل القول بإنا إذا حملناه على الاستغراق كان حملاً له على جميع حقائقه ضرورة اتحاد مدلوله.
الثاني وإن سلمنا أنه حقيقة في كل عدد بخصوصه غير أنه ليس حمله على الاستغراق مع احتمال عدم الإرادة أولى من حمله على الأقل مع كونه مستيقناً.
وأما الوجه الثاني فإنما يلزم المتكلم به بيان إرادة البعض عيناً أن لو كان اللفظ موضوعا له وأما إذا كان موضوعاً لبعض مطلق فلا وأما الاستثناء فقد عرف جوابه كيف وإن أهل اللغة اتفقوا على تسميته نكرة ولو كان للاستغراق لكان معروفاً كله فلا يكون منكراً مختلطاً بغيره.
قولهم: إن العرب فرقت بين تأكيد الواحد والعموم بما ذكروه إنما يصح إن لو كان كلهم أجمعون تأكيداً للعموم وليس كذلك بل هو تأكيد للفظ الذي يجوز أن يراد به العموم وغير العموم.
قولهم: لو لم يكن للعموم صيغة تدل عليه لكان التكليف بالأمور العامة تكليفاً بما لا يطاق قلنا: إنما يكون كذلك إن لو لم يكن ثم ما يدل على التعميم وليس كذلك ولا يلزم من عدم صيغة تدل عليه بوضعها دون قرينة التكليف بالمحال مع وجود صيغة تدل عليه مع القرينة.
وأما شبه أرباب الخصوص: قولهم في الشبهة الأولى أن الخصوص متيقن قلنا: ذلك لا يدل على كونه مجازاً في الزيادة فإن الثلاثة مستيقنة في العشرة ولا يدل على كونه لفظ العشرة
حقيقة في الثلاثة مجازاً في الزيادة فإن قيل إلا أن الزيادة في العشرة على الثلاثة أيضاً مستيقنة قيل ليس كذلك وإلا لما صح استثناؤها بقوله علي عشرة إلا ثلاثة كيف وإن ما ذكروه من الترجيح معارض بما يدل على كونه حقيقة في العموم وذلك لأنه من المحتمل أن يكون مراد المتكلم العموم فلو حمل لفظه على الخصوص لم يحصل مراده وبتقدير أن يكون مراده الخصوص لا يمتنع حصول مقصوده منه بتقدير الحمل على العموم بل المقصود حاصل وزيادة وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.
قولهم في الشبهة الثانية: إن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص لا نسلم ذلك وإن سلم إلا أن ذلك لا يدل على كون هذه الصيغ حقيقة في الخصوص ومجازاً في العموم ويدل عليه أن استعمال لفظ الغائط والعذرة غالب في الخارج المستقذر من الإنسان وإن كان مجازاً فيه وحقيقة في الموضع المطمئن من الأرض وفناء الدار وكذلك لفظ الشجاع حقيقة في الحية المخصوصة وإن كان غالب الاستعمال في الرجل المقدام.
قولهم في الثالثة إنه لا يحسن الاستفهام عن إرادة البعض بخلاف العموم قلنا: حسن الاستفهام عن إرادة العموم لا يخرج الصيغة عن كونها حقيقة في العموم ودليل ذلك أنه لو قال القائل: دخل السلطان البلد ولقيت بحراً وناطحت جبلاً ورأيت حماراً فإنه يحسن استفهامه هل أردت بالسلطان نفسه أو عسكره؟ وهل أردت بالجبل الجبل الحقيقي أو الرجل العظيم وهل أردت بالحمار الحمار الحقيقي أو البليد؟ وأردت بالبحر البحر الحقيقي أو رجلاً كريماً؟ وعدم حسن الاستفهام عن البعض لتيقنه لا يوجب كون الصيغة حقيقية فيه بدليل الثلاثة من العشرة.
قولهم في الرابعة: لو كان قوله رأيت الرجال للعموم لكان كاذباً بتقدير إرادة الخصوص قلنا: إنما يكون كاذباً مع كون لفظه حقيقة في العموم إن لو لم يكن لفظه صالحاً لإرادة البعض تجوزا ولهذا فإنه لو قال: رأيت أسداً وحماراً أو بحراً وكان قد رأى إنساناً شجاعاً وإنساناً بليداً وإنساناً كريماً لم يكن كاذباً وإن كان لفظه حقيقة في غيره وهذا بخلاف ما إذا قال: رأيت عشرة رجال ولم يكن رأى غير خمسة فإن لفظ العشرة مما لا يصلح للخمسة لا حقيقة ولا تجوزاً.
قولهم في الخامسة: إنه لو كانت هذه الصيغ للعموم لكان تأكيدها عبثاً ليس كذلك فإنه يكون أبعد عن مجازفة المتكلم وأبعد عن قبول التخصيص وأغلب على الظن كيف وإنه يلزم على ما ذكروه صحة تأكيد الخاص بقولهم جاء زيد عينه نفسه وتأكيد عقود الأعداد كقوله تعالى: " تلك عشرة كاملة " " البقرة 196 " وما هو الجواب هاهنا عن التأكيد يكون جواباً في العموم.
قولهم: وكان الاستثناء منها نقضاً يلزم عليه الاستثناء من الأعداد المقيدة كقوله له: علي عشرة إلا خمسة فإنه صحيح بالاتفاق مع أن لفظ العشرة صريح فيها وجوابه في الأعداد جوابه في العموم.
قولهم في السادسة: إن من لو كانت للعموم لما جمعت قلنا: قد قيل إن ذلك ليس بجمع وإنما هو إلحاق زيادة الواو وإشباع الحركة وبتقدير أن يكون جمعاً فقد قال سيبويه: إنه لا عمل عليه لما فيه من جمع من حالة الوصل وإنما تجمع عندما إذا حكى بها الجمع المنكر حالة الوقف وإذا ذاك فلا تكون العموم.
وأما شبه أرباب الاشتراك: قولهم في الشبهة الأولى إن هذه الصيغ قد تطلق تارة للعموم وتارة للخصوص والأصل في الإطلاق الحقيقة قلنا: الأصل في الإطلاق الحقيقة بصفة الاشتراك أو لا بصفة الاشتراك الأول ممنوع والثاني مسلم وذلك لأنه إذا كان مشتركاً افتقر في فهم كل واحد من مدلولاته إلى قرينة تعينه ضرورة تساوي نسبة اللفظ فيه إلى الكل والقرينة قد تظهر وقد تخفى وذلك يفضي إلى الإخلال بمقصود الوضع وهو التفاهم وهذا بخلاف ما إذا كان اللفظ حقيقة في مدلول واحد فإنه يحمل عليه عند إطلاقه من غير افتقار إلى قرينة مخلة بالفهم.
قولهم في الثانية: إنه يحسن الاستفهام قلنا: ذلك لا يدل على كون اللفظ مشتركاً فإنه يحسن مع كون اللفظ متحد المدلول كما لو قال القائل: خاصمت السلطان فيقال أخاصمته؟ مع كون اللفظ حقيقة في شيء ومجازاً في غيره كما سبق تمثيله من قول القائل صدمت جبلاً ورأيت بحراً ولقيت حماراً فإنه يحسن استفهامه أنك أردت بذلك المدلولات الحقيقية أو المجازية من الرجل العظيم والكريم والبليد وذلك لفائدة زيادة الأمن من المجازفة في الكلام وزيادة غلبة الظن وتأكده بما اللفظ ظاهر فيه وللمبالغة في دفع المعارض كما سبق في التأكيد.
وأما طريق الرد على من فرق من الواقفية بين الأوامر والأخبار فهو أن كل ما يذكرونه في الدلالة على وجوب التوقف في الأخبار فهو بعينه مطرد في الأوامر.
قولهم أولا إن الأمر تكليف قلنا: ومن الأخبار العامة ما كلفنا بمعرفتها كقوله تعالى: " الله خالق كل شيء " " الزمر 62 " " وهو بكل شيء عليم " " الحديد 3 " وكذلك عمومات الوعد والوعيد فإنا مكلفون بمعرفتها لأن بذلك يتحقق الانزجار عن المعاصي والانقياد إلى الطاعات ومع التساوي في التكليف فلا معنى للفرق وإن سلمنا أن ذلك يفضي إلى التكليف بما لا يطاق فهو غير ممتنع عندنا على ما سبق تقريره.
قولهم ثانياً: إن من الأخبار ما يرد بالمجهول من غير بيان بخلاف الأمر قلنا: لا نسلم امتناع ورود الأمر بالمجهول كيف وإن هذا الفرق وإن دل على عدم الحاجة فيما كان من الأخبار لم نكلف بمعرفتها إلى وضع اللفظ العام بازائه فغير مطرد فيما كلفنا بمعرفته كما سبق وهم غير قائلين بالتفصيل بين خبر وخبر.
المسألة الثالثة اختلف العلماء في أقل الجمع: هل هو اثنان أو ثلاثة؟ وليس محل الخلاف ما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة وهو ضم شيء إلى شيء فإن ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد من غير خلاف وإنما محل النزاع في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة فنقول مذهب عمر وزيد بن ثابت ومالك وداود والقاضي أبي بكر والأستاذ أبي إسحاق وجماعة من أصحاب الشافعي رضي الله عنه كالغزالي وغيره أنه اثنان ومذهب ابن عباس والشافعي وأبي حنيفة ومشايخ المعتزلة وجماعة من أصحاب الشافعي أنه ثلاثة وذهب إمام الحرمين إلى أنه لا يمتنع رد لفظ الجمع إلى الواحد.
احتج الأولون بحجج من جهة الكتاب والسنة وإشعار اللغة والإطلاق.
أما من جهة الكتاب فقوله تعالى: " إنا معكم مستمعون " " الشعراء 15 " وأراد به موسى وهارون وقوله تعالى: " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا " " الحجرات 9 " وقوله تعالى: " وهل أتاك نبؤا الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا: لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض " " ص 21 " وقوله تعالى: " فإن كان له أخوة فلأمه السدس " " النساء 11 " وأراد به الأخوين وقوله تعالى: " عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً " " يوسف 83 " وأراد به يوسف وأخاه وقوله تعالى: " وكنا لحكمهم شاهدين " " الأنبياء 78 " وأراد به داود وسليمان وقوله تعالى: " هذان خصمان اختصموا " " الحج 19 " وقوله تعالى: " إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما " " التحريم 4 " .
وأما من جهة السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الاثنان فما فوقهما جماعة " .
وأما من جهة الإشعار اللغوي فهو أن اسم الجماعة مشتق من الاجتماع وهو ضم شيء إلى شيء وهو متحقق في الاثنين حسب تحققه في الثلاثة وما زاد عليها ولذلك تتصرف العرب وتقول: جمعت بين زيد وعمرو فاجتمعا وهما مجتمعان كما يقال ذلك في الثلاثة فكان إطلاق اسم الجماعة على الاثنين حقيقة.
وأما من جهة الإطلاق فمن وجهين: الأول: أن الاثنين يخبران عن أنفسهما بلفظ الجمع فيقولان: قمنا وقعدنا وأكلنا وشربنا كما تقول الثلاثة.
الثاني: أنه يصح أن يقول القائل إذا أقبل عليه رجلان في مخافة: أقبل الرجال وذلك كله يدل على أن لفظ الجمع حقيقة في الاثنين إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة قال النافون لذلك:
أما قوله تعالى: " إنا معكم مستمعون " " الشعراء 15 " فالمراد به موسى وهارون وفرعون وقومه وهم جمع: وقوله تعالى: " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا " " الحجرات 9 " فكل طائفة جمع وأما قصة داود فلا حجة فيها فإن الخصم قد يطلق على الواحد وعلى الجماعة فيقال هذا خصمي وهؤلاء خصمي وليس في الآية ما يدل على أن كل واحد من الخصمين كان واحداً وقوله تعالى: " فإن كان له أخوة فلأمه السدس " " النساء 11 " فالمراد به الثلاثة وحيث ورثناها السدس مع الأخوين لم يكن ذلك مخالفاً لمنطوق اللفظ بل لمفهومه بدليل آخر وهو انعقاد الإجماع على ذلك والمراد من قوله تعالى: " عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً " " يوسف 83 " يوسف وأخوه وشمعون الذي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي والمراد من قوله تعالى: وكنا لحكمهم شاهدين " " الأنبياء 78 " داود وسليمان والمحكوم له وهم جماعة وقوله تعالى: " هذان خصمان اختصموا " " الحج 19 " فالجواب عنه ما تقدم في قصة داود وقوله تعالى: " إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما " " التحريم 4 " فهو أشبه مما يحتج به هاهنا ويمكن أن يجاب عنه بأن الخطاب وإن كان مع اثنين وأنه ليس لكل واحد منهما في الحقيقة سوى قلب واحد غير أنه قد يطلق اسم القلوب على ما يوجد للقلب الواحد من الترددات المختلفة إلى الجهات المختلفة مجازاً ومن ذلك قولهم لمن مال قلبه إلى جهتين أو تردد بينهما: إنه ذو قلبين وعند ذلك فيجب حمل قوله قلوبكما على جهة لفظ الجمع على الاثنين حقيقة ويمكن أن يقال إنما قال قلوبكما تجوزاً حذراً من استثقال الجمع بين تثنيتين وقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة إنما أراد به أن حكمهما حكم الجماعة في انعقاد صلاة الجماعة بهما وإدراك فضيلة الجماعة ويجب الحمل عليه لأن الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفنا الأحكام الشرعية لا الأمور اللغوية لكونها معلومة للمخاطب ولما سيأتي من الأدلة.
وأما ما ذكروه من الإشعار اللغوي فجوابه أن يقال: وإن كان ما منه اشتقاق لفظ الجماعة في الثلاثة موجوداً في الاثنين فلا يلزم إطلاق اسم الجماعة عليهما إذ هو من باب القياس في اللغة وقد أبطلناه ولهذا فإن المعنى الذي صح منه اشتقاق اسم القارورة للزجاجة المخصوصة وهو قرار المائع فيها متحقق في الجرة والكوز ولا يصح تسميتهما قارورة كيف وإن ذلك لا يطرد في اسم الرجال والمؤمنين وغيرهما من أسماء الجموع إذ هو غير مشتق من الجمع والخلاف واقع في إطلاقه على الاثنين حقيقة.
وجواب الإطلاق الأول أن ذلك لا يدل على أن الاثنين جمع بدليل صحة قول الواحد لذلك مع أنه ليس بجماعة ولهذا فإنه لا يصح إخبار غيرهما عنهما بذلك فلا يقال عن الاثنين قاموا وقعدوا بل قاما وقعدا.
وجواب الإطلاق الثاني أن ذلك أيضاً لا يدل على أن الاثنين جماعة بدليل صحة قوله: جاء الرجال عند ما إذا أقبل عليه الواحد في حال المخافة والواحد ليس بجمع بالاتفاق وأما حجج القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة فست.
الأولى: ما روي عن ابن عباس أنه قال لعثمان حين رد الأم من الثلث إلى السدس بأخوين قال الله تعالى: " فإن كان له أخوة فلأمه السدس " " النساء 11 " وليس الأخوان أخوة في لسان قومك فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي وتوارثه الناس ولولا أن ذلك مقتضى اللغة لما احتج به ابن عباس على عثمان وأقره عليه عثمان وهما من أهل اللغة وفصحاء العرب.
الثانية: أن أهل اللغة فرقوا بين رجلين ورجال فإطلاق اسم الرجال على الرجلين رفع لهذا الفرق.
الثالثة: أنه لو صح إطلاق الرجال على الرجلين لصح نعتهما بما ينعت به الرجال ولا يصح أن يقال: جاءني رجلان ثلاثة كما يقال: جاءني رجال ثلاثة ولصح أن يقال: رأيت اثنين رجالاً كما يقال رأيت ثلاثة رجال.
الرابعة: أن أهل اللغة فرقوا بين ضمير التثنية والجمع فقالوا في الاثنين: فعلاً وفي الجميع فعلوا.
الخامسة: أنه يصح أن يقال: ما رأيت رجالاً بل رجلين ولو كان اسم الرجال للرجلين حقيقة لما صح نفيه.
السادسة: أنه لو قال: لفلان علي دراهم فإنه لا يقبل تفسيره بأقل من ثلاثة وكذلك في النذر والوصية.
وهذه الحجج ضعيفة: أما الحجة الأولى فهي معارضة بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال: الأخوان أخوة وروي عنه أنه قال: أقل الجمع اثنان وليس العمل بأحدهما أولى من الآخر.
وأما الثانية: فهو أن التفرقة بين الرجلين والرجال أن اسم الرجلين جمع خاص بالاثنين والرجال جمع عام للاثنين وما زاد عليهما.
وأما الثالثة: فهو أن الثلاثة نعت للجمع العام وهو الرجال ولا يلزم أن يكون نعتاً للجمع الخاص وهو رجلان وبه يعرف الجواب عن امتناع قولهم: رأيت اثنين رجالاً من حيث إن رجالاً اسم للجمع العام وهو الثلاثة وما زاد عليها فلا يلزم أن يكون اسماً لما دون ذلك وبه يخرج الجواب عن الفرق بين ضمير التثنية وضمير الجمع: فإن ضمير فعلا لجمع خاص وهو الاثنان وفعلوا ضمير ما زاد على ذلك.
وأما الخامسة: فإنه إذا رأى رجلين لا نسلم أنه يصح قوله: ما رأيت رجالاً إلا أن يريد به ما زاد على الاثنين وأما الأحكام فممنوعة على أصل من يرى أن أقل الجمع اثنين.
وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح وإلا فالوقف لازم.
المسألة الرابعة اختلف القائلون بالعموم في العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز على ثمانية مذاهب.
فمنهم من قال إنه يبقى حقيقة مطلقاً على أي وجه كان المخصص وهو مذهب الحنابلة وكثير من أصحابنا.
ومنهم من قال إنه يبقى مجازاً كيف ما كان المخصص وهو مذهب كثير من أصحابنا وإليه ميل الغزالي وكثير من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة كعيسى بن أبان وغيره.
ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن كان الباقي جمعاً فهو حقيقة وإلا فلا وهو اختيار أبي بكر الرازي.
ومنهم من قال إن خص بدليل لفظي فهو حقيقة كيف ما كان المخصص متصلاً أو منفصلاً وإلا فهو مجاز.
ومنهم من قال إن خص بدليل متصل من شرط كقوله: من دخل داري وأكرمني أكرمته أو استثناء كقوله: من دخل داري أكرمته سوى بني تميم فحقيقة وإلا فمجاز وهو اختيار القاضي أبي بكر.
وقال القاضي عبد الجبار من المعتزلة إن كان مخصصه شرطاً كما سبق تمثيله أو تقييداً بصفة كقوله: من دخل داري عالماً أكرمته فهو حقيقة وإلا فهو مجاز حتى في الاستثناء.
وقال أبو الحسين البصري: إن كانت القرينة المخصصة مستقلة بنفسها وسواء كانت عقلية كالدلالة الدالة على أن غير القادر غير مراد بالخطاب في العبادات أو لفظية كقول المتكلم بالعموم: أردت به البعض الفلاني فهو مجاز وإلا فهو حقيقة وسواء كانت القرينة شرطاً أو صفة مقيدة أو استثناء ومن الناس من قال إنه حقيقة في تناول اللفظ له مجاز في الاقتصار عليه.
والمختار تفريعاً على القول بالعموم أنه يكون مجازاً في المستبقى واحداً كان أو جماعة وسواء كان المخصص متصلاً أو منفصلاً عقلياً أو لفظياً باستثناء أو شرط أو تقييد بصفة.
ودليل ذلك أنه إذا كان اللفظ حقيقة في الاستغرق والهيئة الاجتماعية من كل الجنس فصرفه إلى البعض بالقرينة كيف ما كانت القرينة.
إما أن يكون لدلالة اللفظ عليه حقيقة أو مجازاً لا جائز أن يقال بكونه حقيقة فيه وإلا كان اللفظ مشتركاً بينه وبين الاستغراق ضرورة اختلاف معنييهما بالبعضية والكلية وعدم اشتراكهما في معنى جامع يكون مدلولاً للفظ والمشترك لا يكون ظاهراً بلفظه في بعض مدلولاته دون البعض وهو خلاف مذهب القائلين بالعموم فلم يبق إلا أن يكون مجازاً.
فإن قيل: ما المانع أن يكون حقيقة فيهما باعتبار اشتراكهما في الجنسية على وجه لا يكون مشتركاً ولا مجازاً في أحدهما والذي يدل على كونه حقيقة في البعض المستبقي أن اللفظ كان متناولاً له حقيقة قبل التخصيص فخروج غيره عن عموم اللفظ لا يكون مؤثراً فيه سلمنا أنه ليس حقيقة في الجنس المشترك ولكن ما المانع من كون اللفظ بمطلقه حقيقة في الاستغراق ومع القرينة يكون حقيقة في البعض سلمنا امتناع بقائه حقيقة فيه ولكن متى إذا كان دليل التخصيص لفظياً متصلاً أو منفصلاً الأول ممنوع والثاني مسلم وذلك لأنه إذا كان الدليل المخصص لفظياً متصلاً وسواء كان شرطاً أو تقييداً بصفة أو استثناء فإن الكلام يصير بسبب الزيادة المتصلة به كلاماً آخر مستقلاً موضوعاً للبعض فإنه إذا قال من دخل داري أكرمته كان له معنى فإذا زاد شرطاً أو صفة أو استثناء كقوله من دخل داري وأكرمني أكرمته ومن دخل داري عالماً أكرمته أو من دخل داري أكرمته إلا بني تميم تغير ذلك المعنى الأول وصار معنى الشرط الداخل المكرم ومعنى الصفة الداخل العالم ومعنى الاستثناء الداخل ممن ليس من بني تميم فكان اللفظ والمعنى مختلفاً وكل واحد من اللفظين حقيقة في معناه وصار هذا بمنزلة قول القائل: مسلم فإنه له معنى فإذا زاد فيه الألف واللام فقال: المسلم أو زاد فيه الواو والنون فقال: مسلمون فإن اللفظ بإلحاق الزيادة فيه صار دالاً على معنى زائد بجهة الحقيقة لا بجهة التجوز فكذلك فيما نحن فيه.
وعلى هذا نقول: إن قوله تعالى: " فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً " " العنكبوت 14 " إن مجموع هذا القول دل على المستبقي بجهة الحقيقة وهو قائم مقام قوله: فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاماً.
هذا كله فيما إذا كان الاستثناء والمستثنى في كلام متكلم واحد وأما لو قال الله تعالى: " اقتلوا المشركين " " التوبة 5 " فقال الرسول عقيبه: إلا زيداً فهذا مما اختلف فيه أنه كالمتصل الذي لا يجعل لفظ المشركين مجازاً أم لا فمن قال بكونه متصلاً نظر إلى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في تشريع الأحكام يغير الوحي فكان في البيان كما لو كان ذلك بكلام الله تعالى ومنهم من أجراه مجرى الدليل المنفصل دون المتصل ولهذا فإنه لو قال الباري تعالى: زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " قام " لا يكون خبراً صادراً من الله تعالى لأن نظم الكلام إنما يكون من متكلم واحد ولعل هذا هو الأظهر.
سلمنا أنه يكون مجازاً في جميع الصور إلا في الشرط وذلك لأنه إذا قال أكرم بني تميم إن دخلوا داري فإن الشرط لم يخرج شيئاً مما تناوله اللفظ من أعيان الأشخاص بل هو باق بحاله وإنما أخرج حالاً من الأحوال وهي حالة عدم دخول الدار بخلاف الاستثناء وغيره فلا يكون مجازاً.
سلمنا التجوز مطلقاً لكن متى إذا كان المستبقي جمعاً غير منحصر أو إذا لم يكن؟ الأول ممنوع والثاني مسلم.
والجواب عن السؤال الأول أن البعض وإن كان من جنس الكل إلا أن اللفظ العام حقيقة في استغراق الجنس من حيث هو كذلك لا في الجنس مطلقاً ولهذا تعذر حمله على البعض وإن كان من الجنس إلا بقرينة باتفاق القائلين بالعموم ومعنى الاستغراق غير متحقق في المستبقى فلا يكون حقيقة فيه.
قولهم إن اللفظ كان متناولاً له حقيقة قبل التخصيص قلنا بانفراده أو مع المخصص الخارج؟ الأول ممنوع والثاني مسلم وعلى هذا فلا يلزم مع التخصيص أن يبقى حقيقة فيه كيف ويلزم عليه الواحد فإن اللفظ كان متناولاً له حقيقة قبل التخصيص وبعد التخصيص فهو مجاز فيه بالاتفاق.
وعن السؤال الثاني جوابان: الأول أن ذلك مما يرفع جميع المجازات عن الكلام فإنه ما من مجاز إلا ويمكن أن يقال أنه مع القرينة حقيقة في مدلوله وبدون القرينة حقيقة في غيره.
الثاني: أنه لو كان كما ذكروه لكان استعمال ذلك اللفظ في الاستغراق مع اقترانه بالقرينة المخصصة له بالبعض استعمالاً له في غير الحقيقة وصارفاً له عن الحقيقة وهو خلاف إجماع القائلين بالعموم.
وعن السؤال الثالث: أن دلالة اللفظ عند اقترانه بالدليل اللفظي المتصل لا يخرج عن حقيقته وصورته بما اقترن به وإلا كان كل مقترن بشيء خارجاً عن حقيقته ويلزم من ذلك خروج الجسم عن حقيقته من حيث هو جسم عند اتصافه بالسواد والبياض وكذلك في كل موصوف بصفة وهو محال وإذا كان باقياً على حقيقته فمعناه لا يكون مختلفاً بل غايته أن يصير مصروفاً عن معناه بالقرينة المقترنة به وهو التجوز بعينه وعلى هذا فألفاظ الآية المذكورة في قصة نوح الألف للألف والخمسون للخمسين وإلا للرفع ومعرفة ما بقي حاصلة بالحساب وخرج عن هذا زيادة الألف واللام في المسلم والواو والنون في المسلمين فإنها لا معنى لها في نفسها دون المزيد عليه ولا سبيل إلى إهمالها فلذلك كانت موجبة للتعيين في الوضع.
فإن قيل: لو قال: لا إله فإنه بمطلقه يكون كفراً ولو اقترن به الاستثناء وهو قوله: إلا الله كان إيماناً وكذلك لو قال لزوجته: أنت طالق كان بمطلقه تنجيزاً للطلاق ولو اقترن به الشرط وهو قوله: إن دخلت الدار كان تعليقاً مع أن الاستثناء والشرط له معنى ولولا تغير الدلالة والوضع لما كان كذلك.
قلنا: لا نسلم التغير في الوضع بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه في جهة إطلاقه إلى غيره بالقرينة كيف وإنه لو صح ما ذكروه لم يكن ذلك من باب تخصيص العموم الذي نحن فيه. وعن السؤال الرابع من وجهين: الأول: أنه مهما أخرج الشرط بعض الأحوال فيلزم منه إخراج بعض الأعيان وذلك أنه إذا قال: أكرم بني تميم إن دخلوا داري فقد أخرج من لم يدخل الدار الثاني أنه: وإن لم يخرج شيئاً من الأعيان ولكن لا نسلم انحصار التجوز في إخراج الأعيان وما المانع من القول بالتجوز في إخراج بعض الأحوال مع عموم اللفظ بالنسبة إليها؟ وعن السؤال الخامس: لا نسلم أن المستبقي وإن كان جمعاً غير منحصر أنه يكون عاماً إذا لم يكن مستغرقاً للجنس وإن سلمنا عمومه غير أنه بعض مدلول اللفظ العام المخصص وإذا كان بعضاً منه لزم أن يكون صرف اللفظ إليه مجازاً لما ذكرناه من الدليل.
المسألة الخامسة اختلف القائلون بالعموم في صحة الاحتجاج به بعد التخصيص في ما بقي فأثبته الفقهاء مطلقاً وأنكره عيسى بن أبان وأبو ثور مطلقاً ومنهم من فصل: ثم اختلف القائلون بالتفصيل: فقال البلخي إن خص بدليل متصل كالشرط والصفة والاستثناء فهو حجة وإن خص بدليل منفصل فليس بحجة.
وقال أبو عبد الله البصري: إن كان المخصص قد منع من تعلق الحكم بالاسم العام وأوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر لم يجز التعلق به كما في قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " " المائدة 38 " فإن قيام الدلالة على اعتبار الحرز ومقدار المسروق مانع من تعلق الحكم بعموم اسم السارق وموجب لتعلقه بشرط لا ينبئ عنه ظاهر اللفظ وإن كان المخصص لم يمنع من تعلق الحكم الاسم العام فهو حجة كقوله تعالى: " فاقتلوا المشركين " " التوبة 5 " فإن قيام الدلالة على المنع من قتل الذمي غير مانع من تعلق الحكم باسم المشركين.
وقال القاضي عبد الجبار: إن كان العام المخصوص لو تركنا وظاهره من دون التخصيص كنا نمتثل ما أريد منا ونضم إليه ما لم يرد منا صح الاحتجاج به وذلك كقوله تعالى: " فاقتلوا المشركين " " التوبة 5 " المخصص بأهل الذمة وإن كان العام بحيث لو تركنا وظاهره من غير تخصيص لم يمكنا امتثال ما أريد منا دون بيان فلا يكون حجة وذلك كقوله تعالى: " أقيموا الصلاة " " البقرة 110 " فإنا لو تركنا والآية لم يمكنا امتثال ما أريد منا من الصلاة الشرعية قبل تخصيصه بالحائض فكذلك بعد التخصيص.
ومن الناس من قال إنه يكون حجة في أقل الجمع ولا يكون حجة فيما زاد على ذلك واتفق الكل على أن العام لو خص تخصيصاً مجملاً فإنه لا يبقى حجة كما لو قال: اقتلوا المشركين إلا بعضهم والمختار صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص.
وقد احتج بعض الأصحاب على ذلك بأن قال: اللفظ العام كان متناولاً للكل بالإجماع فكونه حجة في كل قسم من أقسام ذلك الكل إما أن يكون موقوفاً على كونه حجة في القسم الآخر أو على كونه حجة في الكل أو لا يتوقف على واحد منهما:
فإن كان الأول فهو باطل لأنه إن كان كونه حجة في كل واحد من الأقسام مشروطاً بكونه حجة في القسم الآخر فهو دور ممتنع وإن كان كونه حجة في بعض الأقسام مشروطاً بكونه حجة في قسم آخر ولا عكس فكونه حجة في ذلك القسم الآخر يبقى بدون كونه حجة في القسم المشروط وليس بعض الأقسام بذلك أولى من البعض مع تساوي نسبة اللفظ العام إلى كل أقسامه.
وإن كان الثاني فهو أيضاً باطل لأن كونه حجة في الكل يتوقف على كونه حجة في كل واحد من تلك الأقسام لأن الكل لا يتحقق إلا عند تحقق جميع الأفراد وذلك أيضاً دور ممتنع وإذا بطل القسمان ثبت كونه حجة في كل واحد من الأقسام من غير توقف على كونه حجة في القسم الآخر ولا على الكل ثبت كونه حجة في البعض المستبقى وإن لم يبق حجة في غيره وهذه الحجة مع طولها ضعيفة جداً إذ لقائل أن يقول ما المانع من صحة توقف الاحتجاج به في كل واحد من الأقسام على الآخر أو على الكل مع التعاكس.
قوله إنه دور ممتنع متى يكون ذلك ممتنعاً إذا كان التوقف توقف معية أو توقف تقدم؟ الأول ممنوع والثاني مسلم ولكن لم قلت بأن التوقف هاهنا بجهة التقدم ولا يخفى أن بيان ذلك مما لا سبيل إليه والمعتمد في ذلك الإجماع والمعقول.
أما الإجماع فهو أن فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبي بكر في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم " " النساء 11 " الآية مع أنه مخصص بالكافر والقاتل ولم ينكر أحد من الصحابة صحة احتجاجها مع ظهوره وشهرته بل عدل أبو بكر في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله صلى الله عليه وسلم: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " وأيضاً فإن علياً عليه السلام احتج على جواز الجمع بين الأختين في الملك بقوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانكم " " النساء 3 " مع كونه مخصصاً بالأخوات والبنات وكان ذلك مشهوراً فيما بين الصحابة ولم يوجد له نكير فكان إجماعاً وأيضاً فإن ابن عباس احتج على تحريم نكاح المرضعة بعموم قوله تعالى: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " " النساء 23 " وقال قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير مع أنه مخصوص لكون الرضاع المحرم متوقفاً على شروط وقيود فليس كل مرضعة محرمة ولم ينكر عليه منكر صحة احتجاجه به فكان إجماعاً.
وأما المعقول فهو أن العام قبل التخصيص حجة في كل واحد من أقسامه إجماعاً والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده إلا أن يوجد له معارض والأصل عدمه فإن قيل: لو كان حجة في الباقي بعد التخصيص لم يخل إما أن يدل عليه حقيقة أو تجوزاً لا جائز أن يقال بالأول إذ يلزم منه أن يكون اللفظ مشتركاً بينه وبين الاستغراق ضرورة اتفاق القائلين بالعموم على كونه حقيقة في الاستغراق والاشتراك على خلاف الأصل وإن كان مجازاً فيمتنع الاحتجاج به لثلاثة أوجه.
الأول: أن المجاز فيما وراء صورة التخصيص ويمتنع الحمل على الكل لما فيه من تكثير جهات التجوز وليس حمله على أحد المجازين أولى من الآخر لعدم دلالة اللفظ عليه فكان مجملاً.
الثاني: أن المجاز ليس بظاهر وما لا يكون ظاهراً لا يكون حجة.
الثالث: أن العام بعد التخصيص ينزل منزلة قوله: اقتلوا المشركين إلا بعضهم والمشبه به ليس بحجة فكذلك المشبه سلمنا أنه حجة لكن في أقل الجمع أو فيما عدا صورة التخصيص؟ الأول مسلم والثاني ممنوع وذلك لأن الحمل على أقل الجمع متيقن بخلاف الحمل على ما زاد عليه فإنه مشكوك فيه فكان حجة في المتيقن والجواب عن السؤال الأول من جهة الإجمال والتفصيل: أما الإجمال فهو أن اللفظ العام حجة في كل واحد من أقسامه قبل التخصيص إجماعاً وهو إما أن يكون دالاً عليه حقيقة أو مجازاً ضرورة وكل ما ذكروه من الإشكالات تكون لازمة ومع ذلك فهو حجة والعذر يكون متحداً.
وأما التفصيل فنقول: ما المانع أن يكون مشتركاً؟ قولهم: الاشتراك على خلاف الأصل قلنا إنما يكون خلاف الأصل أن لو لم يكن من قبيل الأسماء العامة وليس كذلك على ما يأتي عن قرب إن شاء الله تعالى وإن سلمنا أنه ليس مشتركاً فما المانع من التجوز؟
قولهم: إنه مجمل لتردده بين جهات التجوز قلنا: يجب اعتقاد ظهوره في بعضها نفياً للإجمال عن الكلام إذ هو خلاف الأصل ثم متى يكون كذلك إذا كان حمله على ما عدا صورة التخصيص مشهوراً أو إذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلم وبيان اشتهاره ما نقل عن الصحابة من علمهم بالعمومات المخصصة فيما وراء صورة التخصيص نقلاً شائعاً ذائعاً سلمنا أنه غير مشهور فيه ولكن يجب حمل اللفظ بعد التخصيص عليه لأنه أولى من حمله على أقل الجمع لثلاثة أوجه الأول: لكونه معيناً وكون أقل الجمع مبهماً في الجنس.
والثاني: إن حمله عليه بتقدير أن يكون المراد من اللفظ أقل الجمع غير مخل بمراد المتكلم وحمله على أقل الجميع بتقدير أن يكون المراد من اللفظ ما عدا صورة التخصيص مخل بمراد المتكلم فكان الحمل عليه أولى.
والثالث: إنه أقرب إلى الحقيقة فكان أولى.
قولهم: المجاز ليس بظاهر إن أرادوا به أنه ليس حقيقة فمسلم ولكن لا يدل ذلك على أنه لا يكون حجة إلا أن تكون الحجة منحصرة في الحقيقة وهو محل النزاع وإن أرادوا به أنه لا يكون حجة فهو محل النزاع.
قولهم: إنه ينزل منزلة قوله اقتلوا المشركين إلا بعضهم ليس كذلك فإن الخارج عن العموم إذا كان مجهولاً تعذر العمل بالعموم مطلقاً لأن العمل به في أي واحد قدر لا يؤمن معه أن يكون هو المستثنى بخلاف ما إذا كان الخارج معيناً وعن السؤال الثاني بما ذكرناه من الترجيحات السابقة.
المسألة السادسة إذا ورد خطاب جواباً لسؤال سائل داع إلى الجواب فالجواب إما أن يكون غير مستقل بنفسه دون السؤال أو هو مستقل: فإن كان الأول فهو تابع للسؤال في عمومه وخصوصه: أما في عمومه فمن غير خلاف وذلك كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن بيع الرطب التمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم قال: فلا إذا.
وأما في خصوصه فكما لو سأله سائل وقال: توضأت بماء البحر فقال له: يجزئك فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال لا يدل على التعميم في حق الغير كما قاله الشافعي رضي الله عنه إذ اللفظ لا عموم له ولعل الحكم على ذلك الشخص كان لمعنى يختص به كتخصيص أبي بردة في الأضحية بجذعة من المعز وقوله له تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك وتخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده وبتقدير تعميم المعنى الجالب للحكم فالحكم في حق غيره إن ثبت فبالعلة المتعدية لا بالنص.
وأما إن كان الجواب مستقلاً بنفسه دون السؤال فإما أن يكون مساوياً للسؤال أو أعم منه أو أخص.
فإن كان مساوياً له فالحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاماً أو خاصاً فكما لو لم يكن مستقلاً ومثاله عند كون السؤال خاصاً سؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان وقوله صلى الله عليه وسلم: " اعتق رقبة " ومثاله عند كون السؤال عاماً ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقيل له: إنا نركب البحر على أرماث لنا وليس معنا من الماء العذب ما يكفينا أفنتوضأ بما البحر فقال صلى الله عليه وسلم: " البحر هو الطهور ماؤه " .
وأما إن كان الجواب أخص من السؤال فالجواب يكون خاصاً ولا يجوز تعديه الحكم من محل التنصيص إلى غيره إلا بدليل خارج عن اللفظ إذ اللفظ لا عموم له كما سبق تقريره بل وفي هذه الصورة الحكم بالخصوص أولى من القول به فيما إذا كان السؤال خاصاً والجواب مساوياً له حيث إنه هاهنا عدل عن مطابقة سؤال السائل بالجواب مع دعو الحاجة إليه بخلاف تلك الصورة فإنه طابق بجوابه سؤال السائل.
وأما إن كان الجواب أعم من السؤال فإما أن يكون أعم من السؤال في ذلك الحكم لا غير كسؤاله صلى الله عليه وسلم عن ماء بئر بضاعة فقال: " خلق الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه " أو أنه أعم من السؤال في غير ذلك الحكم كسؤاله صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر فقال: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " فإن كان من القسم الثاني فلا خلاف في عمومه في حل ميتته لأنه عام مبتدأ به لا في معرض الجواب إذ هو غير مسؤول عنه وكل عام ورد مبتدأ بطريق الاستقلال فلا خلاف في عمومه عند القائلين بالعموم وأما إن كان من القسم الأول فمذهب أبي حنيفة والجم الغفير أنه عام وأنه لا يسقط عمومه بالسبب الذي ورد عليه والمنقول عن الشافعي رضي الله عنه ومالك والمزني وأبي ثور خلافه.
وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا ورد العام على سبب خاص لا تعلق له بالسؤال كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بشاة ميمونة وهي ميتة فقال صلى الله عليه وسلم: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " .
والمختار إنما هو القول بالتعميم إلى أن يدل الدليل على التخصيص ودليله أنه لو عري اللفظ الوارد عن السبب كان عاماً وليس ذلك إلا لاقتضائه للعموم بلفظه لا لعدم السبب فإن عدم السبب لا مدخل له في الدلالات اللفظية ودلالة العموم لفظية وإذا كانت دلالته على العموم مستفادة من لفظه فاللفظ وارد مع وجوب السبب حسب وروده مع عدم السبب فكان مقتضياً للعموم ووجود السبب لو كان لكان مانعاً من اقتضائه للعموم وهو ممتنع لثلاثة أوجه: الأول: أن الأصل عدم المانعية فمدعيها يحتاج إلى البيان.
الثاني: أنه لو كان مانعاً من الاقتضاء للعموم لكان تصريح الشارع بوجوب العمل بعمومه مع وجود السبب إما إثبات حكم العموم مع انتفاء العموم أو إبطال الدليل المخصص وهو خلاف الأصل.
الثالث: أن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة فآية السرقة نزلت في سرقة المجن أو رداء صفوان وآية الظهار نزلت في حق سلمة بن صخر وآية اللعان نزلت في حق هلال بن أمية إلى غير ذلك والصحابة عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكير فدل على أن السبب غير مسقط للعموم ولو كان مسقطاً للعموم لكان إجماع الأمة على التعميم خلاف الدليل ولم يقل أحد بذلك.
فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بما يدل على اختصاص العموم بالسبب وبيانه من ستة أوجه: الأول: أنه لو لم يكن المراد بيان حكم السبب لا غير بل بيان القاعدة العامة لما أخر البيان إلى حالة وقوع تلك الواقعة واللازم ممتنع وإذا كان المقصود إنما هو بيان حكم السبب الخاص وجب الاقتصار عليه.
الثاني: أنه لو كان الخطاب عاماً لكان جواباً وابتداء وقصد الجواب والابتداء متنافيان.
الثالث: أنه لو كان الخطاب مع السبب عاماً لجاز إخراج السبب عن العموم بالاجتهاد كما في غيره من الصور الداخلة تحت العموم ضرورة تساوي نسبة العموم إلى الكل وهو خلاف الإجماع.
الرابع: أنه لو لم يكن للسبب مدخل في التأثير لما نقله الراوي لعدم فائدته.
الخامس: أنه لو قال القائل لغيره: تغدى عندي فقال: لا والله لا تغديت فإنه وإن كان جواباً عاماً فمقصور على سببه حتى إنه لا يحنث بغدائه عند غيره ولولا أن السبب يقتضي التخصيص لما كان كذلك.
السادس: أنه إذا كان السؤال خاصاً فلو كان الجواب عاما لم يكن مطابقاً للسؤال والأصل المطابقة لكون الزيادة عديمة التأثير فيما تعلق به غرض السائل.
والجواب عن المعارضة الأولى أنها مبنية على وجوب رعاية الغرض والحكمة في أفعال الله وهو غير مسلم وإن كان ذلك مسلماً لكن لا مانع من اختصاص إظهار الحكم عند وجود السبب لحكمة استأثر الرب تعالى بالعلم بها دون غيره ثم يلزم مما ذكروه أن تكون العمومات الواردة على الأسباب الخاصة مما ذكرناه مختصة بأسبابها وهو خلاف الإجماع.
وعن الثانية: أنه إن أريد بالتنافي بين الجواب والابتداء امتناع ذكره لحكم السبب مع غيره فهو محل النزاع وإن أرادوا غير ذلك فلا بد من تصويره.
وعن الثالثة: أنه لا خلاف في كون الخطاب ورد بياناً لحكم السبب فكان مقطوعاً به فيه فلذلك امتنع تخصيصه بالاجتهاد بخلاف غيره فإن تناوله له ظني وهو ظاهر فيه فلذلك جاز إخراجه عن عموم اللفظ بالاجتهاد وما نقل عن أبي حنيفة من أنه كان يجوز إخراج السبب عن عموم اللفظ بالاجتهاد حتى أنه أخرج الأمة المستفرشة عن عموم قوله عليه السلام: " الولد للفراش " ولم يلحق ولدها بمولاها مع وروده في وليد زمعة وقد قال عبد الله بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فلعله فعل ذلك لعدم اطلاعه على ورود الخبر على ذلك السبب.
وعن الرابعة: أن فائدة نقل السبب امتناع إخراجه عن العموم بطريق الاجتهاد ومعرفة أسباب التنزيل.
وعن الخامسة: أن الموجب للتخصيص بالسبب في الصورة المستشهد بها عادة أهل العرف بعضهم مع بعض ولا كذلك في الأسباب الخاصة بالنسبة إلى خطاب الشارع بالأحكام الشرعية.
وعن السادسة: إن أرادوا بمطابقة الجواب للسؤال الكشف عنه وبيان حكمه فقد وجد وإن أرادوا بذلك أن لا يكون بياناً لغير ما سئل عنه فلا نسلم أنه الأصل ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته تعرض لحل الميتة ولم يكن مسؤولاً عنها ولو كان الاقتصار على نفس المسؤول عنه هو الأصل لكان بيان النبي صلى الله عليه وسلم لحل الميتة على خلاف الأصل وهو بعيد.
المسألة السابعة اختلف العلماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركاً بين معنيين كالقرء للطهر والحيض أو حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر كالنكاح المطلق على العقد والوطيء ولم تكن الفائدة فيهما واحدة هل يجوز أن يراد به كلا المعنيين معاً أو لا؟ فذهب الشافعي والقاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا وجماعة من مشايخ المعتزلة كالجبائي والقاضي عبد الجبار وغيرهم إلى جوازه بشرط أن لا يمتنع الجمع بينهما وذلك كاستعمال صيغة افعل في الأمر بالشيء والتهديد عليه غير أن مذهب الشافعي أنه مهما تجرد ذلك اللفظ عن القرينة الصارفة له إلى أحد معنييه وجب حمله على المعنيين ولا كذلك عند من جوز ذلك من مشايخ المعتزلة.
وذهب جماعة من أصحابنا وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري وغيرهما إلى المنع من جواز ذلك مطلقاً.
وفصل أبو الحسين البصري والغزالي فقالا: يجوز ذلك بالنظر إلى الإرادة دون اللغة.
وعلى هذا النحو من الخلاف في اللفظ المفرد اختلفوا في جمعه كالأقراء التي هي جمع قرء هل يجوز حمله على الحيض والإطهار معاً وسواء كان إثباتاً كما لو قيل للمرأة: اعتدي بالأقراء أو نفياً كما لو قيل لها: لا تعتدي بالأقراء وذلك لأن جمع الاسم يفيد جمع ما اقتضاه الاسم فإن كان الاسم متناولاً لمعنييه كان الجمع كذلك وإن كان لا يفيد سوى أحد المعنيين فكذلك أيضاً جمعه والحجاج فيه متفرع على الحجاج في المفرد وربما قال بالتعميم في طرف النفي كان فرداً أو جمعاً بعض من قال بنفيه في طرف الإثبات ولهذا قال أبو الحسين البصري وفيه بعض الاشتباه إذ يجوز أن يقال بنفي الاعتداد بالحيض والطهر معاً والحق أن النفي لما اقتضاه الإثبات فإن كان مقتضى الإثبات الجمع فكذلك النفي وإن كان مقتضاه أحد الأمرين فكذلك النفي.
وإذ أتينا على بيان اختلاف المذاهب بالتفصيل فلنعد إلى طرف الحجاج وقد احتج القائلون بجواز التعميم.
أما في إمكان إرادة الأمرين باللفظ الواحد فهو أنا لو قدرنا عدم التكلم بلفظ القرء لم يمنع الجمع بين إرادة الاعتداد بالحيض وإرادة الاعتداد بالطهر فوجود اللفظ لا يحيل ما كان جائزاً وكذلك الكلام في إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز.
وأما بالنظر عند الوقوع لغة فقوله تعالى: " إن الله وملائكته يصلون على النبي " " الأحزاب 56 " والصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الدعاء والاستغفار وهما معنيان مختلفان وقد أريدا بلفظ واحد وأيضاً قوله تعالى: " ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر " " الحج 18 " إلى آخر الآية وسجود الناس غير سجود غير الناس وقد أريدا بلفظ واحد.
واحتجوا أيضاً بأن سيبويه قال: قول القائل لغيره الويل لك خبر ودعاء فقد جعله مع اتحاده مفيداً لكلا الأمرين.
اعترض النافون أما على إرادة إنكار الجمع بين المسميين فهو أن المتكلم إذا استعمل الكلمة الواحدة في حقيقتها ومجازها معاً كان مريداً لاستعمالها فيما وضعت له ومريداً للعدول بها عما وضعت له وهو محال وأيضاً فإن المستعمل للكلمة فيما هي مجاز فيه لا بد وأن يضمر فيها كاف التشبيه والمستعمل لها في حقيقتها لا بد وأن لا يضمر فيها ذلك والجمع بين الإضمار وعدمه في الكلمة الواحدة محال.
هذا ما يخص الاسم المجازي وأما ما يخص الاسم المشترك فهو أن اللفظ المشترك موضوع في اللغة لأحد أمرين مختلفين على سبيل البدل ولا يلزم من ذلك أن يكون موضوعاً لهما على الجمع إذ المغايرة بين المجموع وبين كل واحد من أفراده واقعة بالضرورة والمساواة بينهما في جميع الأحكام غير لازمة وعلى هذا فلا يلزم من كون كل واحد من المفردين مسمى باسم تسمية المجموع به وعند ذلك فالواضع إذا وضع لفظا لأحد مفهومين على سبيل البدل فإن لم يكن قد وضعه لمجموعهما فاستعماله في المجموع استعمال اللفظ في غير ما وضع له وهو ممتنع وإن كان قد وضعه له فإما أن يستعمل اللفظ لإفادة المجموع وحده أو لإفادته مع إفادة الأفراد.
فإن كان الأول لم يكن اللفظ مفيداً لأحد مفهوماته لأن الواضع إن كان قد وضعه بازاء أمور ثلاثة على البدل واحدها ذلك المجموع فاستعمال اللفظ فيه وحده لا يكون استعمالاً للفظ في جميع مفهوماته وإن استعمله في إفادة المجموع والأفراد على الجمع فهو محال لأن إفادة الجموع معناها أن الاكتفاء لا يحصل إلا به وإفادته للمفرد معناها أنه يحصل الاكتفاء بكل واحد منها وهو جمع بين النقيضين وهو محال فلا يكون اللفظ المشترك من حيث هو مشترك ممكن الاستعمال في إفادة مفهوماته جملة.
وأما على دليل الوقوع لغة أما النص الأول فقد قال الغزالي فيه إن لفظ الصلاة المطلق على صلاة الله تعالى والملائكة إنما هو باعتبار اشتراكهما في معنى العناية بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إظهاراً لشرفه وحرمته فهو لفظ متواطئ لا مشترك وكذلك لفظ السجود في الآية الأخرى فإن مسماه إنما هو القدر المشترك من معنى الخضوع لله تعالى والدخول تحت تسخيره وإرادته وقال أبو هاشم: وإن سلم اختلاف المسمى وإرادتهما بلفظ واحد فلا يبعد أن يقال إن ذلك من قبيل ما نقلته الشريعة من الأسماء اللغوية إلى غير معانيها في اللغة.
فأما قول سيبويه فإنه وإن دل على أن العرب وضعت قوله الويل لك للخبر والدعاء معاً فليس فيه ما يدل على أن كل الألفاظ المشتركة أو الألفاظ التي هي حقيقة في شيء ومجاز في شيء موضوعة للجمع كيف وإن قول سيبويه لا يدل على كون ذلك القول مستعملاً في الخبر والدعاء معاً بل جاز أن يكون موضوعاً للخبر وهو مستعمل في الدعاء مجازاً لا معاً.
أجاب المثبتون عن الاعتراض الأول على الإمكان بمنع أن المستعمل للفظة في حقيقتها ومجازها مريد لاستعمالها فيما وضعت له ومريد للعدول بها عما وضعت له بل هو مريد لما وضعت له حقيقة ولما لم توضع له حقيقة.
وعن الثاني أن إضمار التشبيه وعدمه في الكلمة الواحدة إنما يمتنع بالنسبة إلى شيء واحد وأما بالنسبة إلى شيئين فلا كيف وإن ذلك لا يطرد في كل مجاز.
وعن الثالث أنه مبني على أن الاسم المشترك موضوع لأحد مسمياته على سبيل البدل حقيقة وليس كذلك عند الشافعي والقاضي أبي بكر بل هو حقيقة في المجموع كسائر الألفاظ العامة ولهذا فإنه إذا تجرد عن القرينة عندهما وجب حمله على الجميع وإنما فارق باقي الألفاظ العامة من جهة تناوله لأشياء لا تشترك في معنى واحد يصلح أن يكون مدلولاً للفظ بخلاف باقي العمومات فنسبه اللفظ المشترك في دلالته إلى جملة مدلولاتها وإلى أفرادها كنسبة غيره من الألفاظ العامة إلى مدلولاتها جملة وأفراداً.
وعلى هذا فقد بطل كل ما قيل من التقسيم المبني على أن اللفظ المشترك موضوع لأحد مسمياته على طريق البدل حقيقة ضرورة كونه مبنياً عليه وإنما هو لازم على مشايخ المعتزلة المعتقدين كون اللفظ المشترك موضوعاً لأحد مسمياته حقيقة على طريق البدل.
فإن قيل: وإن كان اللفظ المشترك حقيقة في الجمع فلا خفاء بجواز استعماله في آحاد مدلولاته عند ظهور القرينة عند الشافعي والقاضي أبي بكر وسواء كان ذلك حقيقة أو مجازاً وعند ذلك فاستعماله في المجموع وإن كان على وجه لا يدخل فيه الأفراد فإن كان اللفظ حقيقة في الأفراد فاللفظ يكون مشتركاً ولم يدخل فيه جميع مسمياته وإن كان مجازاً فلم تدخل فيه الحقيقة والمجاز معاً وهو خلاف مذهبكم وإن كان على وجه يدخل فيه الأفراد فهو محال لأن إفادته للمجموع معناها أن الاكتفاء لا يحصل إلا به وإفادته للإفراد معناها أنه يحصل الإكتفاء بكل واحد منها وهو جمع بين النقيضين كما سبق.
قلنا: استعماله في الأفراد متى يكون معناه الاكتفاء بها إذا كانت داخلة في المجموع أو إذا لم تكن داخلة فيه والأول ممنوع بل معنى استعماله فيها أنه لا بد منها والثاني مسلم ولا يلزم منه التناقض على كلا التقديرين أما على تقدير العمل باللفظ في آحاد أفراده مع الاقتصار عند ظهور القرينة فلأن الجملة غير مشترطة في الاكتفاء وأما عند كون الأفراد داخلة في مسمى الجملة فلأنها لا بد منها لا بمعنى أنه يكتفى بها.
فإن قيل: وإذا كانت الأفراد داخلة في مسمى الجملة فليس للفظ عليها دلالة بجهة الحقيقة ولا بجهة التجوز بل بطريق الملازمة الذهنية وليست دلالة لفظية ليلزم ما قيل.
قلنا: لا خفاء بدخول الأفراد في الجملة فتكون مفهومة من اللفظ الدال على الجملة فله عليها دلالة وهي إما أن تكون بجهة الحقيقة أو التجوز لما سبق.
وعن الاعتراض الأول على النصوص أنه لو كان مسمى الصلاة هو القدر المشترك من الاعتناء ومسمى السجود القدر المشترك من الخضوع والانقياد لاطرد الاسم باطرادهما وليس كذلك فإنه لا يسمى كل اعتناء بأمر صلاة ولا كل خضوع وانقياد سجوداً وإن كان المسمى باسم الصلاة اعتناء خاصاً فلا بد من تصويره وبيان الاشتراك فيه.
فإن قيل: يجب اعتقاده نفياً للتجوز والاشتراك عن اللفظ فهو مبني على أن التجوز والاشتراك على خلاف الأصل وإنما يكون كذلك إن لو تعذر الجمع وهو محل النزاع.
وعن اعتراض أبي هاشم أنه مبني على تحقيق الأسماء الشرعية ونقلها من موضوعاتها في اللغة وهو باطل على ما سبق من مذهب القاضي أبي بكر.
وعن الاعتراض على قول سيبويه: أما الأول فلأنه إنما يلزم أن لو كان الاستدلال بقول سيبويه على أن كل لفظ مشترك أو مجاز يجب أن يكون موضوعاً لمجموع مسمياته وليس كذلك بل إنما قصد به بيان الوقوع لا غير.
وأما الثاني فلأنه لا انفكاك في قوله الويل لك عن الخبر والدعاء واللفظ واحد ولا معنى لاستعماله فيهما سوى فهمهما منه عند إطلاقه.
المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين كما في قوله تعالى: " لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " " الحشر 20 " يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور عند أصحابنا القائلين بالعموم خلافاً لأبي حنيفة فإنه قال: إذا وقع التفاوت ولو من وجه واحد فقد وفى بالعمل بدلالة اللفظ.
حجة أصحابنا أنه إذا قال القائل: لا مساواة بين زيد وعمرو فالنفي داخل على مسمى المساواة فلو وجدت المساواة من وجه لما كان مسمى المساواة منتفياً وهو خلاف مقتضى اللفظ.
فإن قيل الاستواء ينقسم إلى الاستواء من كل وجه وإلى الاستواء من بعض الوجوه ولهذا يصدق قول القائل: استوى زيد وعمرو عند تحقق كل واحد من الأمرين والاستواء مطلقاً أعم من الاستواء من كل وجه ومن وجه دون وجه والنفي إنما دخل على الاستواء الأعم فلا يكون مشعراً بأحد القسمين الخاصين وأيضاً فإنه لا يكفي في إطلاق لفظ المساواة الاستواء من بعض الوجوه وإلا لوجب إطلاق لفظ المتساويين على جميع الأشياء لأنه ما من شيئين إلا ولا بد من استوائهما في أمر ما ولو في نفي ما سواهما عنهما ولو صدق ذلك وجب أن يكذب عليه غير المساوي لتناقضهما عرفاً ولهذا فإن من قال: هذا مساو لهذا فمن أراد تكذيبه قال: لا يساويه والمتناقضان لا يصدقان معاً ويلزم من ذلك أن لا يصدق على شيئين أنهما غير متساويين وذلك باطل فعلم أنه لا بد في اعتبار المساواة من التساوي من كل وجه وعند ذلك فيكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لأن نقيض الكلي الموجب جزئي سالب فثبت أن نفي المساواة لا يقتضي نفي المساواة من كل وجه وأيضاً فإنه لو كان نفي المساواة يقتضي نفي المساواة من كل وجه لما صدق نفي المساواة حقيقة على شيئين أصلاً لأنه ما من شيئين إلا وقد استويا في أمر ما كما سبق وهو على خلاف الأصل إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة دون المجاز.
والجواب عن الأول أن ذكر الأعم متى لا يكون مشعراً بالأخص إذا كان ذلك في طرف الإثبات أو النفي؟ الأول مسلم والثاني ممنوع ولهذا فإنه لو قال القائل: " ما رأيت حيواناً وكان قد رأى إنساناً أو غيره من أنواع الحيوان فإنه يعد كاذباً.
وعن الثاني لا نسلم أنه لا يكفي في إطلاق لفظ المساواة التساوي من بعض الوجوه.
قولهم: لو كفى ذلك لوجب إطلاق لفظ المتساويين على جميع الأشياء لما قرر مسلم.
قولهم: يلزم من ذلك أن يكذب عليه غير المساوي وهو باطل بما قرر فهو مقابل بمثله وهو أن يقال لا يكفي في إطلاق نفي المساواة نفي المساواة من بعض الوجوه وإلا لوجب إطلاق نفي المساواة على كل شيئين لأنه ما من شيئين إلا وقد تفاوتا من وجه ضرورة تعينهما ولو صدق ذلك لوجب أن يكذب عليه المساوي لتناقضهما عرفاً ولهذا فإن من قال: هذا غير مساو لهذا فمن أراد تكذيبه قال: إنه مساو له والمتناقضان لا يصدقان معاً ويلزم من ذلك أن لا يصدق على شيئين أنهما متساويان وذلك باطل فإنه ما من شيئين إلا ولا بد من استوائهما ولو في نفي ما سواهما عنهما فعلم أنه لا بد في اعتبار نفي المساواة من نفي المساواة من كل وجه وعند ذلك فيكفي في إثبات المساواة المساواة من بعض الوجوه لأن نقيض الكلي السالب جزئي موجب وفيه إبطال ما ذكر من عدم الاكتفاء في إطلاق لفظ المساواة بالمساواة من وجه وإذا تقابل الأمران سلم لنا ما ذكرناه أولاً.
وعن الثالث لا نسلم صدق نفي المساواة مطلقاً على ما وقع التساوي بينهما من وجه.
قولهم: الأصل في الإطلاق الحقيقة قلنا: إلا أن يدل الدليل على مخالفته ودليله ما ذكرناه وفي معنى نفي المساواة قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً " " النساء 141 " .
المسألة التاسعة المقتضي وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " فإنه أخبر عن رفع الخطأ والنسيان ويتعذر حمله على حقيقته لإفضائه إلى الكذب في كلام الرسول ضرورة تحقق الخطأ والنسيان في حق الأمة فلا بد من إضمار حكم يمكن نفيه من الأحكام الدنيوية أو الأخروية ضرورة صدقه في كلامه وإذا كانت أحكام الخطأ والنسيان متعددة فيمتنع إضمار الجميع إذ الإضمار على خلاف الأصل والمقصود حاصل بإضمار البعض فوجب الاكتفاء به ضرورة تقليل مخالفة الأصل.
فإن قيل: ما ذكرتموه إنما يصح أن لو لم يكن لفظ الرفع دالاً على رفع جميع أحكام الخطأ والنسيان وليس كذلك وبيانه أن قوله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان يدل على رفعهما مستلزماً لرفع أحكامهما فإذا تعذر العمل به في نفي الحقيقة تعين العمل به في نفي الأحكام سلمنا أنه لا دلالة عليها وضعاً ولكن لم قلتم بأنه لا يدل عليها بعرف الاستعمال؟ ولهذا يقال ليس للبلد سلطان وليس له ناظر ولا مدبر والمراد به نفي الصفات سلمنا أنه لا يدل عليها بعرف الاستعمال غير أن اللفظ دال على رفع الخطأ والنسيان فإذا تعذر ذلك وجب إضمار جميع الأحكام لوجهين الأول أنه يجعل وجود الخطأ والنسيان كعدمه والثاني أنه لا يخلو إما أن يقال بإضمار الكل أو البعض أو لا بإضمار شيء أصلاً والقول بعدم الإضمار خلاف الإجماع وليس إضمار البعض أولى من البعض ضرورة تساوي نسبة اللفظ إلى الكل فلم يبق سوى إضمار الجميع.
والجواب: عن الأول أن اللفظ إنما يستلزم نفي الأحكام بواسطة نفي حقيقة الخطأ والنسيان فإذا لم يكن الخطأ والنسيان متيقناً فلا يكون مستلزماً لنفي الأحكام.
وعن الثاني أن الأصل إنما هو العمل بالوضع الأصلي وعدم العرف الطارئ فمن ادعاه يحتاج إلى بيانه وما ذكروه من الاستشهاد بالصور فلا نسلم صحة حملها على جميع الصفات وإلا لما كان السلطان موجوداً ولا عالماً ولا قادراً ونحو ذلك من الصفات وهو محال.
وعن الثالث قولهم: إضمار جميع الأحكام يكون أقرب إلى المقصود من نفي الحقيقة قلنا: إلا أنه يلزم منه تكثير مخالفة الدليل المقتضي للأحكام وهو وجود الخطأ والنسيان.
قولهم ليس إضمار البعض أولى من البعض إنما يصح أن لو قلنا بإضمار حكم معين وليس كذلك بل بإضمار حكم ما والتعيين إلى الشارع فإن قيل فيلزم من ذلك الإجمال في مراد الشارع وهو على خلاف الأصل قلنا: لو قيل بإضمار الكل لزم منه زيادة الإضمار وتكثير مخالفة الدليل كما سبق وكل واحد منهم على خلاف الأصل.
ثم ما ذكرناه من الأصول إما أن تكون راجحة على ما ذكروه أو مساوية له أو مرجوحة فإن كانت راجحة لزم العمل بها.
وإن كانت مساوية فهو كاف لنا في هذا المقام في نفي زيادة الإضمار وهما تقديران وما ذكروه إنما يمكن التمسك به على تقدير كونه راجحاً ولا يخفى أن ما يتم التمسك به على تقديرين أرجح مما لا يمكن التمسك به إلا على تقدير واحد.
المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول كقوله: والله لا آكل أو إن أكلت فأنت طالق هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا؟ اختلفوا فيه: فأثبته أصحابنا والقاضي أبو يوسف ونفاه أبو حنيفة.
وتظهر فائدة الخلاف في أنه لو نوى به مأكولاً معيناً قبل عند أصحابنا حتى إنه لا يحنث بأكل غيره بناء على عموم لفظه له وقبول العام للتخصيص ببعض مدلولاته ولا يقبل عند أبي حنيفة تخصيصه به لأن التخصيص من توابع العموم ولا عموم.
حجة أصحابنا أما في طرف النفي وذلك عند ما إذا قال: والله لا أكلت أن قوله: أكلت فعل يتعدى إلى المأكول ويدل عليه بوضعه وصيغته فإذا قال: لا أكلت فهو ناف لحقيقة الأكل من حيث هو أكل ويلزم من ذلك نفيه بالنسبة إلى كل مأكول وإلا لما كان نافياً لحقيقة الأكل من حيث هو أكل وهو خلاف دلالة لفظه وإذا كان لفظه دالاً على نفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول فقد ثبت عموم لفظه بالنسبة إلى كل مأكول فكان قابلاً للتخصيص.
وأما في طرف الإثبات وهو ما إذا قال: إن أكلت فأنت طالق فلا يخفى أن وقوع الأكل المطلق يستدعي مأكولاً مطلقاً لكونه متعدياً إليه والمطلق ما كان شائعاً في جنس المقيدات الداخلة تحته فكان صالحاً لتفسيره وتقييده بأي منها كان ولهذا لو قال الشارع: أعتق رقبة صح تقييدها بالرقبة المؤمنة ولو لم يكن للمطلق على المقيد دلالة لما صح تفسيره به.
فإن قيل: يلزم على ما ذكرتموه الزمان والمكان فإن حقيقة الأكل لا تتم نفياً ولا إثباتاً إلا بالنسبة إليهما ومع ذلك لو نوى بلفظه مكاناً معيناً أو زماناً معيناً فإنه لا يقبل.
قلنا لا نسلم ذلك وإن سلمنا فالفرق حاصل وذلك لأن الفعل وهو قوله أكلت غير متعد إلى الزمان والمكان بل هو من ضرورات الفعل فلم يكن اللفظ دالاً عليه بوضعه فلذلك لم يقبل تخصيص لفظه به لأن التخصيص عبارة عن حمل اللفظ على بعض مدلولاته لا على غير مدلولاته بخلاف المأكول على ما سبق.
فإن قيل: إذا قال: إن أكلت فأنت طالق فالأكل الذي هو مدلول لفظه كلي مطلق والمطلق لا إشعار له بالمخصص فلا يصح تفسيره به.
قلنا: المحلوف عليه ليس هو المفهوم من الأكل الكلي الذي لا وجود له إلا في الأذهان وإلا لما حنث بالأكل الخاص إذ هو غير المحلوف عليه وهو خلاف الإجماع فلم يبق إلا أن يكون المراد به أكلاً مقيداً من جملة الأكلات المقيدة التي يمكن وقوعها في الأعيان أياً منها كان وإذا كان لفظه لا إشعار له بغير المقيد صح تفسيره به كما إذا قال: أعتق رقبة وفسره بالرقبة المؤمنة كما سبق.
المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها فلا يكون عاماً لجميعها بحيث يحمل وقوعه على جميع جهاته وذلك كما روي عنه عليه السلام أنه صلى داخل الكعبة فصلاته الواقعة يحتمل أنها كانت فرضاً ويحتمل أنها كانت نفلاً ولا يتصور وقوعها فرضاً نفلاً فيمتنع الاستدلال بذلك على جواز الفرض والنفل في داخل الكعبة جميعاً إذ لا عموم للفعل الواقع بالنسبة إليهما ولا يمكن تعيين أحد القسمين إلا بدليل.
وأما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد غيبوبة الشفق فالشفق اسم مشترك بين الحمرة والبياض فصلاته يحتمل أنها وقعت بعد الحمرة ويحتمل أنها وقعت بعد البياض فلا يمكن حمل ذلك على وقوع فعل الصلاة بعدهما على رأي من لا يرى حمل اللفظ المشترك على جميع محامله وإنما يمكن ذلك على رأي من يرى ذلك كما سبق تحقيقه فإن قول الراوي صلى بعد غيبوبة الشفق ينزل منزلة قوله: صلى بعد الشفقين.
وفي هذا المعنى أيضاً قول الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر فإنه يحتمل وقوع ذلك في وقت الأولى ويحتمل وقوعه في وقت الثانية وليس في نفس وقوع الفعل ما يدل على وقوعه فيهما بل في أحدهما والتعين متوقف على الدليل وأما وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم متكرراً على وجه يعم سفر النسك وغيره فليس أيضاً في نفس وقوع الفعل ما يدل عليه بل إن كان ولا بد فاستفادة ذلك إنما هي من قول الراوي كان يجمع بين الصلاتين.
ولهذا فإنه إذا قيل: كان فلان يكرم الضيف يفهم منه التكرار دون القصور على المرة الواحدة.
وعلى هذا أيضاً يجب أن يعلم أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجباً كان عليه أو جائزاً له لا عموم له بالإضافة إلى غيره بل هو خاص في حقه إلا أن يدل دليل من خارج على المساواة بينه وبين غيره في ذلك الفعل كما لو صلى وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " أو غير ذلك.
فإن قيل: فقد أجمعت الأمة على تعميم سجود السهو في كل سهو بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سها في الصلاة فسجد وكذلك اتفقوا على تعميم ما نقل عن عائشة أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة في حق كل أحد حتى إن الشافعي استدل بذلك على طهارة مني الآدمي واستدل به أبو حنيفة على جواز الاقتصار على الفرك في حق غير النبي مع حكمه بنجاسته.
وكذلك إجماعهم على وجوب الغسل من التقاء الختانين بقول عائشة: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن حكم أجاب بما يخصه وأحال معرفة ذلك على فعل نفسه فمن ذلك لما سألته أم سلمة عن الاغتسال قال: أما أنا فأفيض الماء على رأسي ومن ذلك أنه لما سئل عن قبلة الصائم قال أنا أفعل ذلك ولولا أن للفعل عموماً لما كان ذلك.
قلنا: أما تعميم سجود السهو فإنه إنما كان لعموم العلة وهي السهو من حيث إنه رتب السجود على السهو بفاء التعقيب وهو دليل العلة كما يأتي ذكره لا لعموم الفعل وكذلك الحكم في قوله: زنى ماعز فرجم وفي قوله: رضخ يهودي رأس جارية فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
وأما العمل بخبر عائشة في فرك المني ووجوب الغسل من التقاء الختانين وإفاضة الماء على الرأس وقبلة الصائم فكل ذلك مستند إلى القياس لا إلى عموم الفعل لتعذره كما سبق والله أعلم.
المسألة الثانية عشرة قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقوله: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار ونحوه اختلفوا في تعميمه لكل غرر وكل جار.
والذي عليه معول أكثر الأصوليين أنه لا عموم له لأنه حكاية الراوي ولعله رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن فعل خاص لا عموم له فيه غرر وقضى لجار مخصوص بالشفعة فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم ويحتمل أنه سمع صيغة ظنها عامة وليست عامة ويحتمل أنه سمع صيغة عامة وإذا تعارضت الاحتمالات لم يثبت العموم والاحتجاج إنما هو بالمحكي لا بنفس الحكاية.
ولقائل أن يقول: وإن كانت هذه الاحتمالات منقدحة غير أن الصحابي الراوي من أهل العدالة والمعرفة باللغة فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم إلا وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها لما هو مشتمل عليه من الداعي الديني والعقلي المانع له من إيقاع الناس في ورطة الالتباس واتباع ما لا يجوز اتباعه وبتقدير أن لا يكون قاطعاً بالعموم فلا يكون نقله للعموم إلا وقد ظهر له العموم والغالب إصابته فيما ظنه ظاهراً فكان صدقه فيما نقله غالباً على الظن ومهما ظن صدق الراوي فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه.
المسألة الثالثة عشرة مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه تلك العلة خلافاً للقاضي أبي بكر.
وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في حق أعرابي محرم وقصت به ناقته " لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيباً فإنه يحشر يوم القيامة ملبياً " وكقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: " زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماً " وكما لو قال الشارع: حرمت المسكر لكونه حلواً عم التحريم كل حلو.
والحق في ذلك أنه إن ادعى عموم الحكم نظراً إلى الصيغة الواردة فهو باطل قطعاً كيف وإنه لو كان التنصيص على إثبات الحكم المعلل يقتضي بعمومه الحكم في كل محل وجدت فيه العلة لكان للوكيل إذا قال له الموكل اعتق عبدي سالماً لكونه أسود أن يعتق كل عبد أسود له كما لو قال اعتق عبيدي السودان وليس كذلك بالإجماع.
وإن قيل بالعموم نظراً إلى الاشتراك في العلة فهو الحق ولا يلزم من التعميم في الحكم بالعلة المشتركة شرعاً مثله فيما إذا قال لوكيله اعتق عبدي سالماً لكونه أسود إذ الوكيل إنما يتصرف بأمر الموكل لا بالقياس على ما أمره به وعلى هذا فالفائدة في ذكر العلة معرفة كون الحكم معللاً إلا أن يكون اللفظ الدال على الحكم عاما لغير محل التنصيص.
وما يقوله القاضي أبو بكر من أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك في حق الأعرابي بما علمه من موته مسلماً مخلصاً في عبادته محشوراً ملبياً وقصت به ناقته لا بمجرد إحرامه وفي قتلى أحد بعلو درجتهم في الجهاد وتحقق شهادتهم لا بمجرد الجهاد وفي تحريم المسكر لكونه حلواً مسكراً وذلك كله غير معلوم في حق الغير وإن كان ما ذكروه منقدحاً غير أنه على خلاف ما ظهر من تعليله عليه السلام بمجرد الإحرام والجهاد وترك ما ظهر من التعليل لمجرد الاحتمال ممتنع.
المسألة الرابعة عشرة اختلفوا في دلالة المفهوم تفريعاً على القول به: هل لها عموم أو لا؟ وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول: المفهوم ينقسم إلى مفهوم الموافقة وهو ما كان حكم السكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق كما يأتي تحقيقه فإن كان من قبيل مفهوم الموافقة كما في تحريم ضرب الوالدين من تنصيصه على تحريم التأفيف لهما فحكم التحريم وإن كان شاملاً للصورتين لكن مع اختلاف جهة الدلالة فثبوته في صورة النطق بالمنطوق وفي صورة السكوت بالمفهوم فلا المنطوق عام بالنسبة إلى الصورتين ولا المفهوم من غير خلاف وإنما الخلاف في عموم المفهوم بالنسبة إلى صورة السكوت ولا شك أن حاصل النزاع فيه آيل إلى اللفظ.
فإن من قال بكونه عاماً بالنسبة إليهما إنما يريد به ثبوت الحكم به في جميعها لا بالدلالة اللفظية وذلك مما لا خلاف فيه بين القائلين بالمفهوم.
ومن نفي العموم كالغزالي فلم يرد به أن الحكم لم يثبت به في جميع صور السكوت إذ هو خلاف الفرض وإنما أراد نفي ثبوته مستنداً إلى الدلالة اللفظية وذلك مما لا يخالف فيه القائل بعموم المفهوم.
وأما مفهوم المخالفة كما في نفي الزكاة عن المعلوفة من تنصيصه صلى الله عليه وسلم على وجوب الزكاة في الغنم السائمة فلا شك أيضاً بأن اللفظ فيه غير عام بمنطوقه للصورتين ولا بمفهومه وإنما النزاع في عمومه بالنسبة إلى جميع صور السكوت وحاصل النزاع أيضاً فيه آيل إلى اللفظ كما سبق في مفهوم الموافقة.
المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف اختلفوا فيه فمنع أصحابنا من ذلك وأوجبه أصحاب أبي حنيفة رحمه الله.
ومثاله استدلال أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقتل مسلم بكافر " وهو عام بالنسبة إلى كل كافر حربياً كان أو ذمياً.
فقال أصحاب أبي حنيفة: لو كان ذلك عاماً للذمي لكان المعطوف عليه كذلك وهو قوله: ولا ذو عهد في عهده ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته وليس كذلك فإن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد إنما هو الكافر الحربي دون الذمي احتج أصحابنا بثلاثة أمور: الأول أن المعطوف لا يستقل بنفسه في إفادة حكمه واللفظ الدال على حكم المعطوف عليه لا دلالة له على حكم المعطوف بصريحه وإنما أضمر حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الإفادة وحذراً من التعطيل والإضمار على خلاف الأصل فيجب الاقتصار فيه على ما تندفع به الضرورة وهو التشريك في أصل الحكم دون تفصيله من صفة العموم وغيره تقليلاً لمخالفة الدليل.
الثاني: أنه قد ورد عطف الخاص على العام في قوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " " البقرة 228 " فإنه عام في الرجعية والبائن وقوله: " وبعولتهن أحق بردهن " " البقرة 228 " خاص وورد عطف الواجب على المندوب في قوله تعالى: " فكاتبوهم " " النور 33 " فإنه للندب وقوله: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " " النور 33 " للإيجاب وورد عطف الواجب على المباح في قوله تعالى: " كلوا من ثمره إذا أثمر " " الأنعام 141 " فإنه للإباحة وقوله: " وآتوا حقه " " الأنعام 141 " للإيجاب ولو كان الأصل هو الاشتراك في أصل الحكم وتفصيله لكان العطف في جميع هذه المواضع على خلاف الأصل وهو ممتنع.
الثالث: أن الاشتراك في أصل الحكم متيقن وفي صفته محتمل فجعل العطف أصلاً في المتيقن دون المحتمل أولى.
فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما يدل على وجوب التشريك بينهما في أصل الحكم وتفصيله وبيانه من وجهين.
الأول: أن حرف العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في حكم جملة واحدة فالحكم على أحدهما يكون حكماً على الأخرى.
الثاني: أن المعطوف إذا لم يكن مستقلاً بنفسه فلا بد من إضمار حكم المعطوف عليه فيه لتحقق الإفادة وعند ذلك لا يخلو إما أن يقال بإضمار كل ما ثبت للمعطوف عليه للمعطوف أو بعضه لا جائز أن يقال بالثاني لأن الإضمار إما لبعض معين أو غير معين: القول بالتعيين ممتنع إذ هو غير واقع من نفس العطف كيف وإنه ليس البعض أولى من البعض الآخر والقول بعدم التعيين موجب للإبهام والإجمال في الكلام وهو خلاف الأصل فلم يبق سوى القسم الأول وهو المطلوب.
قلنا: جواب الأول أن العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في حكم جملة واحدة فيما فيه العطف أو في غيره؟ الأول مسلم والثاني ممنوع فلم قلتم إن ما زاد على أصل الحكم معتبر في العطف إذ هو محل النزاع.
وجواب الثاني أن نقول بالتشريك في أصل الحكم المذكور دون صفته وهو مدلول اللفظ من غير إبهام ولا إجمال.
المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى: " يا أيها المزمل قم الليل " " المزمل 1 " " يا أيها المدثر قم فأنذر " " المدثر 1 " " يا أيها النبي اتق الله لئن أشركت ليحبطن عملك " لا يعم الأمة ذلك الخطاب عند أصحابنا خلافاً لأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما في قولهم إنه يكون خطاباً للأمة إلا ما دل الدليل فيه على الفرق.
ودليلنا في ذلك أن الخطاب الوارد نحو الواحد موضوع في أصل اللغة لذلك الواحد فلا يكون متناولاً لغيره بوضعه ولهذا فإن السيد إذا أمر بعض عبيده بخطاب يخصه لا يكون أمراً للباقين وكذلك في النهي والإخبار وسائر أنواع الخطاب كيف وإنه من المحتمل أن يكون الأمر للواحد المعين مصلحة له وهو مفسدة في حق غيره وذلك كما في أمر الطبيب لبعض الناس بشرب بعض الأدوية فإنه لا يكون ذلك أمراً لغيره لاحتمال التفاوت بين الناس في الأمزجة الأحوال المقتضية لذلك الأمر ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام لم يشاركه فيها أحد من أمته من الواجبات والمندوبات والمحظورات والمباحات ومع امتناع اتحاد الخطاب وجواز الاختلاف في الحكمة والمقصود يمتنع التشريك في الحكم اللهم إلا أن يقوم دليل من خارج يدل على الاشتراك في العلة الداعية إلى ذلك الحكم فالاشتراك في الحكم يكون مستنداً إلى نفس القياس لا إلى نفس الخطاب الخاص بمحل التنصيص أو دليل آخر.
فإن قيل: نحن لا ننكر أن الخطاب الخاص بالواحد لا يكون خطاباً لغيره مطلقاً بل المدعي أن من كان مقدماً على قوم وقد عقدت له الولاية والإمارة عليهم وجعل له منصب الاقتداء به فإنه إذا قيل له: اركب لمناجزة العدو وشن الغارة عليه وعلى بلاده فإن أهل اللغة يعدون ذلك أمراً لأتباعه وأصحابه وكذلك إذا أخبر عنه بأنه قد فتح البلد الفلاني وكسر العدو فإنه يكون إخباراً عن أتباعه أيضاً والنبي صلى الله عليه وسلم ممن قد ثبت كونه قدوة للأمة ومتبعاً لهم فأمره ونهيه يكون أمراً ونهياً لأمته إلا ما دل الدليل فيه على الفرق ويدل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " " الطلاق 1 " ولم يقل إذا طلقت النساء فطلقهن وذلك يدل على أن خطابه خطاب لأمته وأيضاً قوله تعالى: " فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً " " الأحزاب 37 " أخبره أنه إنما أباحه ذلك ليكون ذلك مباحاً للأمة ولو كانت الإباحة خاصة به لما انتفى الحرج عن الأمة وأيضاً فإنه قد ورد الخطاب بتخصيصه عليه السلام بأحكام دون أمته كقوله تعالى: " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " " الأحزاب 35 " إلى قوله: " خالصة لك من دون المؤمنين " " الأحزاب 35 " وكقوله تعالى: " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " " الإسراء 1 " ولو لم يكن الخطاب المطلق له خطاباً لأمته بل خاصاً به لما احتيج إلى بيان التخصيص به هاهنا.
وما ذكرتموه من احتمال التفاوت في المصلحة والمفسدة فغير قادح مع ظهور المشاركة في الخطاب كما تقرر ولهذا جاز تكليف الكل مع هذا الاحتمال لظهور الخطاب وجاز تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع عند ظن الاشتراك في الداعي مع احتمال التفاوت بين الأصل والفرع في المصلحة والمفسدة.
والجواب لا نسلم أن أمر المقدم يكون أمراً لاتباعه لغة ولهذا فإنه يصح أن يقال: أمر المقدم ولم يأمر الأتباع وأنه لو حلف أنه لم يأمر الأتباع لم يحنث بالإجماع ولو كان أمره للمقدم أمراً لاتباعه لحنث نعم غايته أنه يفهم عند أمر المقدم بالركوب وشن الغار لزوم توقف مقصود الأمر على اتباع أصحابه له فكان ذلك من باب الاستلزام لا من باب دلالة اللفظ مطابقة ولا ضمناً ولا يلزم مثله في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العبادات أو بتحريم شيء من الأفعال أو إباحتها من حيث إنه لا يتوقف المقصود من ذلك على مشاركة الأمة له في ذلك.
وقوله تعالى: " إذا طلقتم النساء " " الطلاق 1 " فخطاب عام مع الكل على وجه يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمة وتخصيص النبي في أول الآية بالنداء جرى مجرى التشريف والتكريم له كيف وإن في الآية ما يدل على أن خطاب النبي لا يكون خطاباً للأمة فإنه لو كان كذلك لما احتيج إلى قوله: " طلقتم النساء فطلقوهن " لأن قوله: " إذا طلقت النساء فطلقهن " كاف في خطاب الأمة مع اتساقه مع أول الآية.
وقوله تعالى: " فلما قضى زيد منها وطراً " " الأحزاب 37 " لا حجة فيه على المقصود وقوله: " لكي لا يكون على المؤمنين حرج " ليس فيه ما يدل على أن نفي الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم مدلول لقوله: " زوجناكها " بل غايته أن رفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لمقصود رفع الحرج عن المؤمنين وذلك حاصل بقياسهم عليه بواسطة دفع الحاجة وحصول المصلحة وعموم الخطاب غير متعين لذلك.
وما ذكروه من الآيات الدالة على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكروه لا يدل على أن مطلق الخطاب له عام لأمته بل إنما كان ذلك لقطع إلحاق غيره به في تلك الأحكام بطريق القياس ولو لم يرد التخصيص لأمكن الإلحاق بطريق القياس.
المسألة السابعة عشرة اختلفوا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أمته: هل هو خطاب للباقين أم لا؟ فنفاه أصحابنا وأثبته الحنابلة وجماعة من الناس ودليلنا ما سبق في المسألة التي قبلها.
فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالنص والإجماع والمعنى أما النص فقوله تعالى: " وما أرسلناك إلا كافة للناس " " سبأ 28 " وقوله صلى الله عليه وسلم: " بعثت إلى الناس كافة وبعثت إلى الأحمر والأسود " وقوله: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " .
وأما الإجماع فاتفاق الصحابة على رجوعهم في أحكام الحوادث إلى ما حكم به النبي عليه السلام على آحاد الأمة فمن ذلك رجوعهم في حد الزنا إلى ما حكم به على ماعز ورجوعهم في المفوضة إلى قصة بروع بنت واشق ورجوعهم في ضرب الجزية على المجوس إلى ضربه عليه السلام الجزية على مجوس هجر ولولا أن حكمه على الواحد حكم على الجماعة لما كان كذلك.
وأما المعنى فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص بعض الصحابة بأحكام دون غيره فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في التضحية بعناق " تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك " وقوله لأبي بكرة لما دخل الصف راكعاً زادك الله حرصاً ولا تعد " وقوله لأعرابي زوجه بما معه من القرآن هذا لك وليس لأحد بعدك وتخصيصه لخزيمة بقبول شهادته وحده وتخصيصه لعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير ولولا أن الحكم بإطلاقه على الواحد حكم على الأمة لما احتاج إلى التنصيص بالتخصيص.
والجواب عن الآية وعن قوله " بعثت إلى الناس كافة وإلى الأحمر والأسود " أنه وإن كان مبعوثاً إلى الناس كافة فبمعنى أنه يعرف كل واحد ما يختص به من الأحكام كأحكام المريض والصحيح والمقيم والمسافر والحر والعبد والحائض والطاهر وغير ذلك ولا يلزم من ذلك اشتراك الكل فيما أثبت للبعض منهم.
وعن قوله: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " أنه يجب تأويله على أن المراد به أنه حكم على الجماعة من جهة المعنى والقياس لا من جهة اللفظ لثلاثة أوجه.
الأول: أن الحكم هو الخطاب وقد بينا في المسألة المتقدمة أن خطاب الواحد ليس هو بعينه خطاباً للباقين.
الثاني: أنه لو كان بعينه خطاباً للباقين لزم منه التخصيص بإخراج من لم يكن موافقاً لذلك الواحد في السبب الموجب للحكم عليه.
الثالث: أنه لو كان خطابه المطلق للواحد خطاباً للجماعة لما احتاج إلى قوله: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " أو كانت فائدته التأكيد والأصل في الدلالات اللفظية إنما هو التأسيس ثم وإن كان حكمه على الواحد حكماً على الجماعة فلا يلزم اطراده في حكمه للواحد أن يكون حكماً للجماعة فإنه فرق بين حكمه للواحد وحكمه عليه والخلاف واقع في الكل.
وأما ما ذكروه من رجوع الصحابة في أحكام الوقائع إلى حكمه على الآحاد فلا يخلو إما أن يقال بذلك مع معرفتهم بالتساوي في السبب الموجب أو لا مع معرفتهم بذلك الثاني خلاف الإجماع وإن كان الأول فمستند التشريك في الحكم إنما كان الاشتراك في السبب لا في الخطاب وأما المعنى فقد سبق الجواب عنه في المسألة المتقدمة.
المسألة الثامنة عشرة اتفق العلماء على أن كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر كالرجال والنساء وعلى دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث كالناس وإنما وقع الخلاف بينهم في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين والمؤمنين هل هو ظاهر في دخول الإناث فيه أو لا؟ فذهبت الشافعية والأشاعرة والجمع الكثير من الحنفية والمعتزلة إلى نفيه وذهبت الحنابلة وابن داود وشذوذ من الناس إلى إثباته احتج النافون بالكتاب والسنة والمعقول: أما الكتاب فقوله تعالى: " إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات " " الأحزاب 35 " عطف جمع التأنيث على جمع المسلمين والمؤمنين ولو كان داخلاً فيه لما حسن عطفه عليه لعدم فائدته.
وأما السنة فما روي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إن النساء قلن: ما نرى الله ذكر إلا الرجال فأنزل الله: " إن المسلمين والمسلمات " الآية ولو كن قد دخلن في جمع التذكير لكن مذكورات وامتنعت صحة السؤال والتقرير عليه وأيضاً ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " " ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون " فقالت عائشة: هذا للرجال فما للنساء؟ ولولا خروجهن من جمع الذكور لما صح السؤال ولا التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما المعقول فهو أن الجمع تضعيف الواحد فقولنا: قام لا يتناول المؤنث بالإجماع فالجمع الذي هو تضعيفه كقولنا: قاموا لا يكون متناولاً له.
فإن قيل: أما الآية فالعطف فيها لا يدل على عدم دخول الإناث في جمع التذكير قولكم: لا فائدة فيه ليس كذلك إذ المقصود منه إنما هو الإتيان بلفظ يخصهن تأكيداً فلا يكون عرياً عن الفائدة.
وأما سؤال أم سلمة وعائشة فلم يكن لعدم دخول النساء في جمع الذكور بل لعدم تخصيصهن بلفظ صريح فيهن كما ورد في المذكر.
وأما قولكم إن الجمع تضعيف الواحد فمسلم ولكن لم قلتم بامتناع دخول المؤنث فيه مع أنه محل النزاع والذي يدل على دخول المؤنث في جمع التذكير ثلاثة أمور: الأول: أن المألوف من عادة العرب أنه إذا اجتمع التذكير والتأنيث غلبوا جانب التذكير ولهذا فإنه يقال للنساء إذا تمحضن: أدخلن وإن كان معهن رجل قيل: ادخلوا قال الله تعالى لآدم وحواء وإبليس: " قلنا اهبطوا منها جميعاً " " البقرة 38 " كما ألف منهم تغليب جمع من يعقل إذا كان معه من لا يعقل ومنه قوله تعالى: " والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه " " النور 45 " بل أبلغ من ذلك أنهم إذا وصفوا ما لا يعقل بصفة من يعقل غلبوا فيه من يعقل ومنه قوله تعالى: " أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين " " يوسف 4 " جمعهم جمع من يعقل لوصفهم بالسجود الذي هو صفة من يعقل وكتغليبهم الكثرة على القلة حتى إنهم يصفون بالكرم والبخل جمعاً أكثرهم متصف بالكرم أو البخل وكتغليبهم في التثنية أحد الاسمين على الآخر كقولهم: الأسودان للتمر والماء والعمران لأبي بكر وعمر والقمران للشمس والقمر.
الثاني: أنه يستهجن من العربي أن يقول لأهل حلة أو قرية أنتم آمنون ونساؤكم آمنات لحصول الأمن للنساء بقوله أنتم آمنون ولولا دخولهن في قوله أنتم آمنون لما كان كذلك وكذلك لا يحسن منه أن يقول لجماعة فيهم رجال ونساء قوموا وقمن بل لو قال قوموا كان ذلك كافياً في الأمر للنساء بالقيام ولولا دخولهن في جمع التذكير لما كان كذلك.
الثالث: أن أكثر أوامر الشرع بخطاب المذكر مع انعقاد الإجماع على أن النساء يشاركن الرجال في أحكام تلك الأوامر ولو لم يدخلن في ذلك الخطاب لما كان كذلك.
والجواب: قولهم في الآية فائدة التخصيص بلفظ يخصهن التأكيد قلنا: لو اعتقدنا عدم دخولهن في جمع التذكير كانت فائدة تخصيصهن بالذكر التأسيس ولا يخفى أن فائدة التأسيس أولى في كلام الشارع.
قولهم: سؤال أم سلمة وعائشة إنما كان لعدم تخصيص النساء بلفظ يخصهن لا لعدم دخول النساء في جمع التذكير ليس كذلك أما سؤال أم سلمة فهو صريح في عدم الذكر مطلقاً لا في عدم ذكر ما يخصهن بحيث قالت: ما نرى الله ذكر إلا الرجال ولو ذكر النساء ولو بطريق الضمن لما صح هذا الإخبار على إطلاقه وأما حديث عائشة فلأنها قالت هذا للرجال ولو كان الحكم عاماً لما صح منها تخصيص ذلك بالرجال.
قولهم: المألوف من عادة العرب تغليب جانب التذكير مسلم ونحن لا ننازع في أن العربي إذا أراد أن يعبر عن جمع فيهم ذكور وإناث أنه يغلب جانب التذكير ويعبر بلفظ التذكير ويكون ذلك من باب التجوز وإنما النزاع في أن جمع التذكير إذا أطلق هل يكون ظاهراً في دخول المؤنث ومستلزماً له أو لا؟ وليس فيما قيل ما يدل على ذلك وهذا كما أنه يصح التجوز بلفظ الأسد عن الإنسان ولا يلزم أن يكون ظاهرا فيه مهما أطلق.
فإن قيل: إذا صح دخول المؤنث في جمع المذكر فالأصل أن يكون مشعراً به حقيقة لا تجوزاً.
قلنا: ولو كان جمع التذكير حقيقة للذكور والإناث مع انعقاد الإجماع على أنه حقيقة في تمحض الذكور كان اللفظ مشتركاً وهو خلاف الأصل.
فإن قيل: ولو كان مجازاً لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد لدخول المسمى الحقيقي فيه وهم الذكور وهو ممتنع.
قلنا: ليس كذلك فإنه لا يكون حقيقة في الذكور إلا مع الاقتصار وأما إذا كان جزءاً من المذكور لا مع الاقتصار فلا كيف وإنا لا نسلم امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز كما سبق تقريره.
وأما الوجه الثاني: فإنما استهجن من العربي أن يقول: أنتم آمنون ونساؤكم آمنات لأن تأمين الرجال يستلزم الأمن من جميع المخاوف المتعلقة بأنفسهم وأموالهم ونسائهم فلو لم تكن النساء آمنات لما حصل أمن الرجال مطلقاً وهو تناقض أما أن ذلك يدل على ظهور دخول النساء في الخطاب فلا وبه يظهر لزوم أمن النساء من الاقتصار على قوله للرجال: أنتم آمنون.
وأما الوجه الثالث: فغير لازم وذلك أن النساء وإن شاركن الرجال في كثير من أحكام التذكير فيفارقن للرجال في كثير من الأحكام الثابتة بخطاب التذكير كأحكام الجهاد في قوله تعالى: " وجاهدوا في الله حق جهاده " " الحج 78 " وأحكام الجمعة في قوله تعالى: " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " " الجمعة 9 " إلى غير ذلك من الأحكام ولو كان جمع التذكير مقتضياً لدخول الإناث فيه لكان خروجهن عن هذه الأوامر على خلاف الدليل وهو ممتنع فحيث وقع الاشتراك تارة والافتراق تارة علم أن ذلك إنما هو مستند إلى دليل خارج لا إلى نفس اقتضاء اللفظ لذلك.
المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث سوى لفظ الجمع مثل من في الشرط والجزاء هل يعم المذكر والمؤنث؟ اختلفوا فيه فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون.
والمختار تفريعاً على القول بالعموم دخول المؤنث فيه ودليله أنه لو قال القائل لعبده من دخل داري فأكرمه فإن العبد يلام بإخراج الداخل من المؤنثات عن الإكرام ويلام السيد بلوم العبد بإكرامهن وكذلك الحكم في النذر والوصية والأصل في كل ما فهم من اللفظ أن يكون حقيقة فيه لا مجازاً.
فإن قيل: التعميم فيما ذكرتموه إنما فهم من قرينة الحال وهي ما جرت به العادة من مقابلة الداخل إلى دار الإنسان والحلول في منزله بالإكرام فكان ذلك من باب المجاز لا أنه من مقتضيات اللفظ حقيقة.
قلنا: هذا باطل بما لو قال: من دخل داري فأهنه فإنه يفهم منه العموم وإن كان على خلاف القرينة المذكورة وكذا لو قال له: من قال لك ألف فقل له ب فإنه لا قرينة أصلاً والعموم مفهوم منه فدل على كونه حقيقة فيه.
المسألة العشرون اختلفوا في دخول العبد تحت خطاب التكاليف بالألفاظ العامة المطلقة كلفظ الناس والمؤمنين فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون إلا بقرينة ودليل يخصه ومنهم من قال بدخوله في العمومات المثبتة لحقوق الله دون حقوق الآدميين وهو منسوب إلى أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة.
والمختار إنما هو الدخول وذلك لأن الخطاب إذا كان بلفظ الناس أو المؤمنين فهو خطاب لكل من هو من الناس والمؤمنين والعبد من الناس والمؤمنين حقيقة فكان داخلاً في عمومات الخطاب بوضعه لغة إلا أن يدل دليل على إخراجه منه.
فإن قيل: العبد من حيث هو عبد مال لسيده ولذلك يتمكن من التصرف فيه حسب تصرفه في سائر الأموال وإذا كان مالاً كان بمنزلة البهائم فلا يكون داخلاً تحت عموم خطاب الشارع سلمنا أنه ليس كالبهائم إلا أن أفعاله التي يتعلق بها التكليف ويحصل بها الامتثال مملوكة لسيده ويجب صرفها إلى منافعه بخطاب الشرع فلا يكون الخطاب متعلقاً بصرفها إلى غير منافع السيد لما فيه من التناقض سلمنا عدم التناقض غير أن الإجماع منعقد على إخراج العبد عن مطلق الخطاب العام بالجهاد والحج والعمرة والجمعة والعمومات الواردة بصحة التبرع والإقرار بالحقوق البدنية والمالية ولو كان داخلاً تحت عموم الخطاب بمطلقه لكان خروجه عنها في هذه الصور على خلاف الدليل سلمنا إمكان دخوله تحت مطلق الخطاب لغة إلا أن الرق مقتض لإخراجه عن عمومات الخطاب بطريق التخصيص وبيانه أنه صالح لذلك من حيث إنه مكلف بشغل جميع أوقاته بخدمة سيده بخطاب الشرع وحق السيد مقدم على حق الله تعالى لوجهين: الأول: أن السيد متمكن من منع العبد من التطوع بالنوافل مع أنها حق لله تعالى ولولا أن حق السيد مرجح لما كان كذلك.
الثاني: أن حق الله تعالى مبني على المسامحة والمساهلة لأنه لا يتضرر بفوات حقوقه ولا ينتفع بحصولها وحق الآدمي مبني على الشح والمضايقة لأنه ينتفع بحصوله ويتضرر بفواته.
والجواب عن السؤال الأول: أن كون العبد مالاً مملوكاً لا يخرجه عن جنس المكلفين إلى جنس البهائم وإلا لما توجه نحو التكليف بالخطاب الخاص بالصلاة والصوم ونحوه وهو خلاف الإجماع.
وعن السؤال الثاني: لا نسلم أن السيد مالك لصرف منافع العبد إليه في جميع الأوقات حتى في وقت تضايق وقت العبادة المأمور بها بل في غيره وعلى هذا فلا تناقض.
وعن الثالث: أن ذلك لا يدل على إخراج العبد عن كون العمومات متناولة له لغة لما بيناه بل غايته أنه خص بدليل والتخصيص غير مانع من العموم لغة ولا يخفى أن القول بالتخصيص أولى من القول برفع العموم لغة مع تحققه وصار كما في تخصيص المريض والحائض والمسافر عن العمومات الواردة بالصوم والصلاة والجمعة والجهاد.
وعن الرابع: بمنع تعلق حق السيد بمنافعه المصروفة إلى العبادات المأمور بها عند ضيق أوقاتها كما سبق والرق وإن اقتضى ذلك لمناسبته واعتباره فلا يقع في مقابلة الدلالة النصية على العبادة في ذلك الوقت لقوة دلالة النصوص على دلالة ما الحجة به مستندة إليها والنصوص وإن كانت متناولة للعبد بعمومها إلا أنها متناولة للعبادة في وقتها المعين بخصوصها والرق وإن كان مقتضياً لحق السيد بخصوصه إلا أن اقتضاءه لذلك الحق في وقت العبادة بعمومه فيتقابلان ويسلم الترجيح بالتنصيص كما سبق.
قولهم: حق الآدمي مرجح على حق الله تعالى لا نسلم ذلك مطلقاً ولهذا فإن حق الله تعالى مرجح على حق السيد فيما وجب على العبد بالخطاب الخاص به إجماعاً وبه يندفع ما ذكروه من الترجيح الأول.
قولهم في الترجيح الثاني إن السيد يتمكن من منع العبد من التنفل قلنا وإن أوجب ذلك ترجح جانب حق السيد على حقوق الله تعالى في النوافل فغير موجب لترجحه عليه في الفرائض.
المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: " يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا عبادي " " يدخل الرسول في عمومه عندنا وعند أكثر العلماء خلافاً لطائفة من الفقهاء والمتكلمين ومنهم من قال: كل خطاب ورد مطلقاً ولم يكن الرسول مأموراً في أوله بأمر الأمة به كهذه الآيات فهو داخل فيه وإليه ذهب أبو بكر الصيرفي والحليمي من أصحاب الشافعي حجة من قال: يدخل في العموم وهو المختار حجتان.
الأولى: أن هذه الصيغ عامة لكل إنسان وكل مؤمن وكل عبد والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس والمؤمنين والعبادة والنبوة غير مخرجة له عن إطلاق هذه الأسماء عليه فلا تكون مخرجة له عن هذه العمومات.
الحجة الثانية: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر الصحابة بأمر وتخلف عنه ولم يفعله فإنهم كانوا يسألونه ما بالك لم تفعله؟ ولو لم يعقلوا دخوله فيما أمرهم به لما سألوه عن ذلك وذلك كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ولم يفسخ فقالوا له: أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ ولم ينكر عليهم ما فهموه من دخوله في ذلك الأمر بل عدل إلى الاعتذار وهو قوله: إني قلدت هديا وروي عنه أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة.
فإن قيل: يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داخلاً تحت عموم هذه الأوامر ثلاثة أوجه: الأول: أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم آمراً لأمته بهذه الأوامر فلو كان مأموراً بها لزم من ذلك أن يكون بخطاب واحد آمراً ومأموراً وهو ممتنع ولأنه يلزم أن يكون آمراً لنفسه وأمر الإنسان لنفسه ممتنع لوجهين: الأول: أن الأمر طلب الأعلى من الأدنى والواحد لا يكون أعلى من نفسه وأدنى منها.
الثاني: أنه وقع الاتفاق على أن أمر الإنسان لنفسه على الخصوص ممتنع فكذلك أمره لنفسه على العموم.
الثاني: من الوجوه الثلاثة أنه يلزم من ذلك أن يكون بخطاب واحد مبلغاً ومبلغاً إليه وهو محال.
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص بأحكام لم تشاركه فيها الأمة كوجوب ركعتي الفجر والضحى والأضحى وتحريم الزكاة عليه وأبيح له النكاح بغير ولي ولا مهر ولا شهود والصفي من المغنم ونحوه من الخصائص وذلك يدل على مزيته وانفراده عن الأمة في الأحكام التكليفية فلا يكون داخلاً تحت الخطاب المتناول لهم.
قلنا: جواب الأول أن ما ذكروه مبني على كون الرسول آمراً وليس كذلك بل هو مبلغ لأمر الله وفرق بين الآمر والمبلغ للأمر ولهذا أعاد صيغ الأوامر له بالتبليغ كقوله: " قل أوحي إلي " " الجن 1 " " واتل ما أوحي إليك " " الكهف 27 " ونحوه.
وجواب الثاني: أنه مبلغ للأمة بما ورد على لسانه وليس مبلغاً لنفسه بذلك الخطاب بل بما سمعه من جبريل عليه السلام.
وجواب الثالث: أن اختصاصه ببعض الأحكام غير موجب لخروجه عن عمومات الخطاب
ولهذا فإن الحائض والمريض والمسافر والمرأة كل واحد قد اختص بأحكام لا يشاركه غيره فيها ولم يخرج بذلك عن الدخول في عمومات الخطاب والله أعلم بالصواب.
المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاهاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأوامر العامة كقوله تعالى: " يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا " ونحوه هل يخص الموجودين في زمنه أو هو عام لهم ولمن بعدهم؟ اختلفوا فيه: فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والمعتزلة إلى اختصاصه بالموجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت حكمه في حق من بعدهم إلا بدليل آخر وذهبت الحنابلة وطائفة من السالفين والفقهاء إلى تناول ذلك لمن وجد بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم حجة النافين من وجهين: الأول: أن المخاطبة شفاها بقوله تعالى: " يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا " تستدعي كون المخاطب موجوداً أهلاً للخطاب إنساناً مؤمناً ومن لم يكن موجوداً في وقت الخطاب لم يكن متصفاً بشيء من هذه الصفات فلا يكون الخطاب متناولاً له.
الثاني: أن خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز ممتنع حتى إن من شافهه بالخطاب استهجن كلامه وسفه في رأيه مع أن حالهما لوجودهما واتصافهما بصفة الإنسانية وأصل الفهم وقبولهما للتأديب بالضرب وغيره أقرب إلى الخطاب لهما ممن لا وجود له احتج الخصوم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: " وما أرسلناك إلا كافة للناس " " سبأ 28 " وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: " بعثت إلى الأحمر والأسود " ولو لم يكن خطابه متناولاً لمن بعده لم يكن رسولاً إليه ولا مبلغاً إليه شرع الله تعالى وهو خلاف الإجماع وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " ولفظ الجماعة يستغرق كل من بعده فلو لم يكن حكمه على من في زمانه حكماً على غيرهم كان على خلاف الظاهر.
وأما الإجماع فهو أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وإلى زماننا هذا ما زالوا يحتجون في المسائل الشرعية على من وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات والأخبار الواردة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولولا عموم تلك الدلائل اللفظية لمن وجد بعد ذلك لما كان التمسك بها صحيحاً وكان الاسترواح إليها خطأ وهو بعيد عن أهل الإجماع.
وأما المعقول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد التخصيص ببعض الأمة نص عليه كما ذكرناه في مسألة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد هل هو خطاب للباقين؟ ولولا أن الخطاب المطلق العام يكون خطاباً للكل لما احتاج إلى التخصيص.
والجواب على النصوص الدالة على كون النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم مبعوثاً إلى الناس كافة أنها إنما تلزم أن لو توقف مفهوم الرسالة والبعثة إلى كل الناس على المخاطبة للكل بالأحكام الشرعية شفاهاً وليس كذلك بل ذلك يتحقق بتعريف البعض بالمشافهة وتعريف البعض بنصب الدلائل والأمارات وقياس بعض الوقائع على بعض ويدل على ذلك أن أكثر الأحكام الشرعية لم يثبت بالخطاب شفاهاً لقلة النصوص وندرتها وكثرة الوقائع وما لزم من ذلك أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم رسولاً ولا مبلغاً بالنسبة إلى الأحكام التي لم تثبت بالخطاب شفاهاً.
فإن قيل: والدلائل التي يمكن الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية على من وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير الخطاب فيما ذكرتموه إنما يعلم كونها حجة بالدلائل الخطابية فإذا كان الخطاب الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول من بعده فقد تعذر الاحتجاج به عليه.
قلنا: أمكن معرفة كونها حجة بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بكونها حجة على من بعده أو بالإجماع المنقول عن الصحابة على ذلك.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " فالكلام في اختصاصه بالموجودين في زمنه كالكلام في الأول.
وأما انعقاد الإجماع على صحة الاستدلال بالآيات والأخبار الواردة على لسانه صلى الله عليه وسلم على من وجد بعده وهو أشبه حجج الخصوم فجوابه أنا بينا امتناع المخاطبة لمن ليس بموجود بما لا مراء فيه وعند ذلك فيجب اعتقاد استناد أهل الإجماع إلى النصوص من جهة معقولها لا من جهة ألفاظها جمعاً بين الأدلة.
وأما ما ذكروه من المعنى فقد سبق جوابه في مسألة خطاب النبي للواحد من الأمة.
المسألة الثالثة والعشرون اختلفوا في المخاطب: هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا؟ والمختار دخوله وعليه اعتماد الأكثرين وسواء كان خطابه العام أمراً أو نهياً أو خبراً.
أما الخبر فكما في قوله تعالى: " وهو بكل شيء عليم " " الحديد 3 " فإن اللفظ بعمومه يقتضي كون كل شيء معلوماً لله تعالى وذاته وصفاته أشياء فكانت داخلة تحت عموم الخطاب.
والأمر فكما لو قال السيد لعبده من أحسن إليك فأكرمه فإن خطابه لغة يقتضي إكرام كل من أحسن إلى العبد فإذا أحسن السيد إليه صدق عليه أنه من جملة المحسنين إلى العبد فكان إكرامه على العبد لازماً بمقتضى عموم خطاب السيد.
وكذلك في النهي كما إذا قال له: من أحسن إليك فلا تسيء إليه وهذا في الوضوح غير محتاج إلى الإطناب فيه.
فإن قيل: ما ذكرتموه يمتنع العمل به للنص والمعنى: أما النص فقوله تعالى: " الله خالق كل شيء " " الزمر 62 " وذاته وصفاته أشياء وهو غير خالق لها ولو كان داخلاً في عموم خبره لكان خالقاً لها وهو محال.
وأما المعنى فإن السيد إذا قال لعبده: من دخل داري فتصدق عليه بدرهم ولو دخل السيد فإنه يصدق عليه أنه من الداخلين إلى الدار ومع ذلك لا يحسن أن يتصدق عليه العبد بدرهم ولو كان داخلاً تحت عموم أمره لكان ذلك حسناً.
قلنا: أما الآية فإنها بالنظر إلى عموم اللفظ تقتضي كون الرب تعالى خالقاً لذاته وصفاته غير أنه لما كان ممتنعاً في نفس الأمر عقلاً كان مخصصاً لعموم الآية ولا منافاة بين دخوله في العموم بمقتضى اللفظ وخروجه عنه بالتخصيص وكذلك الحكم فيما ذكروه من المثال فإنه بعمومه مقتض للتصدق على السيد عند دخوله غير أنه بالنظر إلى القرينة الحالية والدليل المخصص امتنع ثبوت حكم العموم في حقه ولا منافاة كما سبق.
المسألة الرابعة والعشرون اختلف العلماء في قوله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة " " التوبة 103 " هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك أو أخذ صدقة واحدة من نوع واحد؟ والأول مذهب الأكثرين والثاني مذهب الكرخي.
احتج القائلون بتعميم كل نوع بأنه تعالى أضاف الصدقة إلى جميع الأموال بقوله: " من أموالهم " والجمع المضاف من ألفاظ العموم على ما عرف من مذهب أربابه فنزل ذلك منزلة قوله: خذ من كل نوع من أموالهم صدقة فكانت الصدقة متعددة بتعدد أنواع الأموال.
وللنافي أن يقول المأمور به صدقة منكرة مضافة إلى جملة الأموال فمهما أخذ من نوع واحد منها من المالك صدقة صدق قول القائل أخذ من أمواله صدقة لأن المال الواحد جزء من جملة الأموال فإذا أخذت الصدقة من جزء المال صدق أخذها من المال.
ولهذا وقع الإجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف بأنه من ماله ومع ذلك فإنه لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار ودرهم له والأصل أن يكون ذلك لعدم دلالة اللفظ عليه لا للمعارض وبالجملة فالمسألة محتملة ومأخذ الكرخي دقيق.
المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح كقوله تعالى: " إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم " " الانفطار 14 " وكقوله: " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " " التوبة 34 " .
نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه منع من عمومه حتى أنه منع من التمسك به في وجوب زكاة الحلي مصيراً منه إلى أن العموم لم يقع مقصوداً في الكلام وإنما سيق لقصد الذم والمدح مبالغة في الحث على الفعل أو الزجر عنه.
وخالفه الأكثرون وهو الحق من حيث إن قصد الذم أو المدح وإن كان مطلوباً للمتكلم فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه إذ لا منافاة بين الأمرين وقد أتى بالصيغة الدالة على العموم فكان الجمع بين المقصودين أولى ومن العمل بأحدهما وتعطيل الآخر والله أعلم.
الصنف الرابع في تخصيص العموم ويشتمل على مقدمة ومسألتين أما المقدمة ففي بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز أما التخصيص فقد قال أبو الحسين البصري: هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه وذلك مما لا يمكن حمله على ظاهره على كل مذهب.
أما على مذهب أرباب الخصوص فلأن الخطاب عندهم منزل على أقل ما يحتمله اللفظ فلا يتصور إخراج شيء منه.
وأما على مذهب أرباب الاشتراك فمن جهة أن العمل باللفظ المشترك في بعض محامله لا يكون إخراجاً لبعض ما تناوله الخطاب عنه بل غايته استعمال اللفظ في بعض محامله دون البعض.
وأما على مذهب أرباب الوقف فظاهر إذ اللفظ عندهم موقوف لا يعلم كونه للخصوص أو للعموم وهو صالح لاستعماله في كل واحد منهما فإن قام الدليل على أنه أريد به العموم وجب حمله عليه وامتنع إخراج شيء منه وإن قام الدليل على أنه للخصوص لم يكن اللفظ إذ ذاك دليلاً على العموم ولا متناولاً له فلا يتحقق بالحمل على الخاص إخراج بعض ما تناوله اللفظ على بعض محامله الصالح لها.
وأما على مذهب أرباب العموم فغايته أن اللفظ عندهم حقيقة في الاستغراق ومجاز في الخصوص وعلى هذا فإن لم يقم الدليل على مخالفة الحقيقة وجب إجراء اللفظ على جميع محامله من غير إخراج شي منها وإن قام الدليل على مخالفة الحقيقة وامتناع العمل باللفظ في الاستغراق وجب صرفه إلى محمله المجازي وهو الخصوص وعند حمل اللفظ على المجاز لا يكون اللفظ متناولاً للحقيقة وهي الاستغراق فلا تحقق لإخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه إذ هو حالة كونه مستعملاً في المجاز لا يكون مستعملاً في الحقيقة وعلى هذا فإطلاق القول بتخصيص العام أو أن هذا عام مخصص لا يكون حقيقة.
وإذا عرف ذلك فالتخصيص على ما يناسب مذهب أرباب العموم هو تعريف أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة إنما هو الخصوص وعلى ما يناسب مذهب أرباب الاشتراك تعريف أن المراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص إنما هو الخصوص والمعرف لذلك بأي طريق كان يسمى مخصصاً واللفظ المصروف عن جهة العموم إلى الخصوص مخصصاً.
وإذا عرف معنى تخصيص العموم فاعلم أن كل خطاب لا يتصور فيه معنى الشمول كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة " تجزئك ولا تجزيء أحداً بعدك " فلا يتصور تخصيصه لأن التخصيص على ما عرف صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص وما لا عموم له لا يتصور فيه هذا الصرف وأما ما يتصور فيه الشمول والعموم فيتصور فيه التخصيص وسواء كان خطاباً أو لم يكن خطاباً كالعلة الشاملة لإمكان صرفه عن جهة عمومه إلى خصوصه هذا إتمام المقدمة.
وأما المسائل فمسألتان: المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان من الأخبار والأمر وغيره خلافاً لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيصه الخبر ويدل على جواز ذلك الشرع والمعقول: أما الشرع فوقوع ذلك في كتاب الله تعالى كقوله تعالى: " الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير " " الزمر 62 " وليس خالقاً لذاته ولا قادراً عليها وهي شيء وقوله تعالى: " ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم " " الذاريات 42 " وقد أتت على الأرض والجبال ولم تجعلها رميماً وقوله تعالى: " تدمر كل شيء " " الأحقاف 25 " " وأوتيت من كل شيء " " النحل 23 " إلى غير ذلك من الآيات الخبرية المخصصة حتى إنه قد قيل لم يرد عام إلا وهو مخصص إلا في قوله تعالى: " وهو بكل شيء عليم " " الحديد 3 " ولو لم يكن ذلك جائزاً لما وقع في الكتاب.
وأما المعقول فهو أنه لا معنى لتخصص العموم سوى صرف اللفظ عن جهة العموم الذي هو حقيقة فيه إلى جهة الخصوص بطريق المجاز كما سبق تقريره والتجوز غير ممتنع في ذاته ولهذا لو قدرنا وقوعه لم يلزم المحال عنه لذاته ولا بالنظر إلى وضع اللغة ولهذا يصح من اللغوي أن يقول: جاءني كل أهل البلد وإن تخلف عنه بعضهم ولا بالنظر إلى الداعي إلى ذلك.
والأصل عدم كل مانع سوى ذلك ويدل على جواز تخصيص الأوامر العامة وإن لم نعرف فيها خلافاً قوله تعالى: " فاقتلوا المشركين " مع خروج أهل الذمة عنه وقوله تعالى: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " " المائدة 38 " " والزانية والزاني فاجدلوا كل واحد منهما مائة جلدة " " النور 2 " مع أنه ليس كل سارق يقطع ولا كل زان يجلد وقوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " " النساء 11 " مع خروج الكافر والرقيق والقاتل عنه.
فإن قيل: القول بجواز تخصيص الخبر مما يوجب الكذب في الخبر لما فيه من مخالفة المخبر للخبر وهو غير جائز على الشارع كما في نسخ الخبر.
قلنا: لا نسلم لزوم الكذب ولا وهم الكذب بتقدير إرادة جهة المجاز وقيام الدليل على ذلك وإلا كان القائل إذا قال: رأيت أسداً وأراد به الإنسان أن يكون كاذباً إذا تبينا أنه لم يرد الأسد الحقيقي وليس كذلك بالإجماع وعلى هذا فلا نسلم امتناع نسخ الخبر كما سيأتي تقريره.
المسألة الثانية اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها: فمنهم من قال بجواز انتهاء التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد ومنهم من أجاز ذلك في من خاصة دون ما عداها من أسماء الجموع كالرجال والمسلمين وجعل نهاية التخصيص فيها أن يبقى تحتها ثلاثة وهذا هو مذهب القفال من أصحاب الشافعي ومنهم من جعل نهاية التخصيص في جميع الألفاظ العامة جمعاً كثيراً يعرف من مدلول اللفظ وإن لم يكن محدوداً وهو مذهب أبي الحسين البصري وإليه ميل إمام الحرمين وأكثر أصحابنا احتج من جوز الانتهاء في التخصيص إلى الواحد بالنص والإطلاق والمعنى.
وأما النص فقوله تعالى: " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " " الحجر 9 " وأراد به نفسه وحده.
وأما الإطلاق فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص وقد أنفذ إليه القعقاع مع ألف فارس قد أنفذت إليك ألفي رجل أطلق اسم الألف الأخرى وأراد بها القعقاع.
وأما المعنى فمن وجهين: الأول أنه لو امتنع الانتهاء في التخصيص إلى الواحد فإما أن يكون لأن الخطاب صار مجازاً أو لأنه إذا استعمل اللفظ فيه لم يكن مستعملاً فيما هو حقيقة فيه من الاستغراق وكل واحد من الأمرين لو قيل بكونه مانعاً لزم امتناع تخصيص العام مطلقاً ولا بعدد ما لأنه يكون مجازاً في ذلك العدد وغير مستعمل فيما هو حقيقة فيه وذلك خلاف الإجماع.
الثاني: أن استعمال اللفظ في الواحد من حيث إنه بعض من الكل يكون مجازاً كما في استعماله في الكثرة فإذا جاز التجوز باللفظ العام عن الكثرة فكذا في الواحد.
ولقائل أن يقول: أما الآية فهي محمولة على تعظيم المتكلم وهو بمعزل عن التخصيص بالواحد.
وأما الإطلاق العمري فمحمول على قصد بيان أن ذلك الواحد قائم مقام الألف وهو غير معنى التخصيص.
وأما المعنى الأول فلا نسلم الحصر فيما قيل من القسمين بل المنع من ذلك إنما كان لعدم استعماله لغة.
وأما المعنى الثاني فمبني على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الواحد مجازاً وهو محل النزاع.
وأما حجة أبي الحسين البصري فإنه قال: لو قال القائل: قتلت كل من في البلد وأكلت كل رمانة في الدار وكان فيها تقدير ألف رمانة وكان قد قتل شخصاً واحداً أو ثلاثة وأكل رمانة واحدة أو ثلاث رمانات فإن كلامه يعد مستقبحاً مستهجناً عند أهل اللغة وكذلك إذا قال لعبده: من دخل داري فأكرمه أو قال لغيره: من عندك وقال: أردت به زيداً وحده أو ثلاثة أشخاص معينة أو غير معينة كان قبيحاً مستهجناً ولا كذلك فيما إذا حمل على الكثرة القريبة من مدلول اللفظ فإنه يعد موافقاً مطابقاً لوضع أهل اللغة.
وهذه الحجة وإن كانت قريبة من السداد وقد قلده فيها جماعة كثيرة إلا أن لقائل أن يقول: متى يكون ذلك مستهجناً منه إذا كان مريداً للواحد من جنس ذلك العدد الذي هو مدلول اللفظ وقد اقترن به قرينة أو إذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلم وبيان ذلك النص وصحة الإطلاق.
أما النص فقوله تعالى: " الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم " " آل عمران 173 " وأراد بالناس القائلين نعيم بن مسعود الأشجعي بعينه ولم يعد ذلك مستهجناً لاقترانه بالدليل.
وأما الإطلاق فصحة قول القائل: أكلت الخبز واللحم وشربت الماء والمراد به واحد من جنس مدلولات اللفظ العام ولم يكن ذلك مستقبحاً لاقترانه بالدليل.
نعم إذا أطلق اللفظ العام وكان الظاهر منه إرادة الكل وما يقاربه في الكثرة وهو مريد للواحد البعيد من ظاهر اللفظ من غير اقتران دليل به يدل عليه فإنه يكون مستهجناً وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فعليك بالاجتهاد في الترجيح.
الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم وهي قسمان متصلة ومنفصلة القسم الأول في الأدلة المتصلة وهي أربعة أنواع: الاستثناء والشرط والصفة والغاية النوع الأول: الاستثناء
وفيه مقدمة ومسائل أما المقدمة ففي معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه أما الاستثناء فقال الغزالي: هو قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول وهو باطل من وجهين: الأول: أنه ينتقض بآحاد الاستثناءات كقولنا: جاء القوم إلا زيداً فإنه استثناء حقيقة وليس بذي صيغ بل صيغة واحدة وهي إلا زيداً.
الثاني: أنه يبطل بالأقوال الموجبة لتخصيص العموم الخارجة عن الاستثناء فإنها صيغ مخصوصة وهي محصورة لاستحالة القول بعدم النهاية في الألفاظ الدالة وهي دالة على أن المذكور بها لم يرد بالقول الأول وليست من الاستثناء في شيء وذلك كما لو قال القائل: رأيت أهل البلد ولم أر زيداً واقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة ومن دخل داري فأكرمه والفاسق منهم أهنه وأهل البلد كلهم علماء وزيد جاهل إلى غير ذلك.
وقال بعض المتبحرين من النحاة: الاستثناء إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه وهو منتقض بقول القائل: رأيت أهل البلد ولم أر زيداً فإنه قائم مقام قوله: إلا زيداً في إخراج بعض الجملة عن الجملة وليس باستثناء.
وقيل: إنه عبارة عما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظ إلا ولا يستقل بنفسه وهو أيضاً مدخول من وجهين: الأول: أن الاستثناء لا لإخراج بعض الكلام وإنما يكون إخراجاً لبعض ما دل عليه الكلام الأول وفرق بين الأمرين.
الثاني: أنه لو قال القائل: جاء القوم غير زيد فإنه استثناء مع أن لفظة غير قد وجد فيها جميع ما ذكروه من القيود سوى قوله: لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه فإن غير قد يدخل في الكلام لغرض النعتية إذا لم يجز في موضعها إلا كقولك: عندي درهم غير جيد فإنه لا يحسن أن تقول في موضعها عندي درهم إلا جيداً فلا جرم كانت نعتاً للدرهم وتابعة له في إعرابه وهذا بخلاف ما إذا قلت عندي درهم غير قيراط فإن غير تكون استثنائية منصوبة لإمكان دخول إلا في موضعها ويمكن أن يقال هاهنا إن النعتية ليست استثنائية فلا ترد على الحد.
والمختار في ذلك أن يقال: الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف إلا أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية.
فقولنا: لفظ احتراز عن الدلالات العقلية والحسية الموجبة للتخصيص وقولنا: متصل بجملة احتراز عن الدلائل المنفصلة وقولنا: ولا يستقل بنفسه احتراز عن مثل قولنا: قام القوم وزيد لم يقم وقولنا: دال احتراز عن الصيغ المهملة وقولنا: على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به احتراز عن الأسماء المؤكدة والنعتية كقول القائل جاءني القوم العلماء كلهم وقولنا بحرف إلا أو أخواتها احتراز عن قولنا قام القوم دون زيد وفيه احتراز عن أكثر الإلزامات السابق ذكرها وقولنا: ليس بشرط احتراز عن قول القائل لعبده: من دخل داري فأكرمه إن كان مسلماً وقولنا ليس بصفة احتراز من قول القائل: جاءني بنو تميم الطوال وقولنا: ليس بغاية احتراز عن قول القائل لعبده: أكرم بني تميم أبداً إلى أن يدخلوا الدار وهذا الحد مطرد منعكس لا غبار عليه.
وإذا عرف معنى الاستثناء فصيغه كثيرة وهي: إلا وغير وسوى وخلا وحاشا وعدا وما عدا وما خلا وليس ولا يكون ونحوه وأم الباب في هذه الصيغ إلا لكونها حرفاً مطلقا ولوقوعها في جميع أبواب الاستثناء لا غير ولها أحكام مختلفة في الإعراب مستقصاة في كتب أهل الأدب لا مناسبة لذكرها فيما نحن فيه كما قد فعله من غلب عليه حب العربية.
وهو منقسم إلى الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس كما يأتي تحقيقه عن قريب إن شاء الله تعالى ويجوز أن يكون متأخراً عن المستثنى منه كما ذكرناه من الأمثلة وأن يكون متقدماً عليه مع الاتصال كقولك خرج إلا زيداً القوم ومنه قول الكميت:
فما لي إلا أحمد شيعة ... وما لي إلا مذهب الحق مذهب
ويجوز الاستثناء من الاستثناء من غير خلاف كقول القائل: له علي عشرة دراهم إلا أربعة إلا اثنين ويدل عليه قوله تعالى: " إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين " " الحجر 58 " إلى قوله: " إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته " " الحجر 59 " استثنى آل لوط من أهل القرية واستثنى المرأة من الآل المنجين من الهلاك وهذا ما أردنا ذكره من المقدمة وأما المسائل فخمس: المسألة الأولى
شرط صحة الاستثناء عند أصحابنا وعند الأكثرين أن يكون متصلاً بالمستثنى منه حقيقة من غير تخلل فاصل بينهما أو في حكم المتصل وهو ما لا يعد المتكلم به آتياً به بعد فراغه من كلامه الأول عرفاً وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع النفس أو سعال مانع من الاتصال حقيقة ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول بصحة الاستثناء المنفصل وإن طال الزمان شهراً.
وذهب بعض أصحاب مالك إلى جواز تأخير الاستثناء لفظاً لكن مع إضمار الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه ويكون المتكلم به مديناً فيما بينه وبين الله تعالى ولعله مذهب ابن عباس.
وذهب بعض الفقهاء إلى صحة الاستثناء المنفصل في كتاب الله تعالى دون غيره حجة القائلين بالاتصال من ثلاثة أوجه.
الأول: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " وروي " فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير " ولو كان الاستثناء المنفصل صحيحاً لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه لكونه طريقاً مخلصاً للحالف عند تأمل الخير في البر وعدم الحنث لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصد التيسير والتسهيل ولا يخفى أن الاستثناء أيسر وأسهل من التكفير فحيث لم يرشد إليه دل على عدم صحته.
الثاني: أن أهل اللغة لا يعدون ذلك كلاماً منتظماً ولا معدوداً من كلام العرب ولهذا فإنه لو قال: لفلان علي عشرة دراهم ثم قال بعد شهر أو سنة إلا درهماً أو قال: رأيت بني تميم ثم قال بعد شهر: إلا زيداً فإنه لا يعد استثناء ولا كلاماً صحيحاً كما لو قال رأيت زيداً ثم قال بعد شهر: قائماً فإنهم لا يعدونه بذلك مخبراً عن زيد بشيء وكذلك لو قال السيد لعبده: أكرم زيداً ثم قال بعد شهر: إن دخل داري فإنهم لا يعدون ذلك شرطاً.
الثالث: أنه لو قيل بصحة الاستثناء المنفصل لما علم صدق صادق ولا كذب كاذب ولا حصل وثوق بيمين ولا وعد ولا وعيد ولا حصل الجزم بصحة عقد نكاح وبيع وإجارة ولا لزوم معاملة أصلاً لإمكان الاستثناء المنفصل ولو بعد حين ولا يخفى ما في ذلك من التلاعب وإبطال التصرفات الشرعية وهو محال.
احتج الخصوم بأربعة أمور: الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " والله لأغزون قريشاً ثم سكت وقال بعده إن شاء الله " ولولا صحة الاستثناء بعد السكوت لما فعله لكونه مقتدى به وأيضاً ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته اليهود عن عدة أهل الكهف وعن مدة لبثهم فيه فقال: " غداً أجيبكم " ولم يقل إن شاء الله فتأخر عنه الوحي مدة بضعة عشر يوماً ثم نزل عليه: " ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً " " الكهف 22 " إلى قوله: " ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " " الكهف 23 " فقال: إن شاء الله بطريق الإلحاق بخبره الأول ولو لم يكن ذلك صحيحاً لما فعله.
الثاني: أن ابن عباس ترجمان القرآن ومن أفصح فصحاء العرب وقد قال بصحة الاستثناء المنفصل وذلك يدل على صحته.
الثالث: أن الاستثناء بيان وتخصيص للكلام الأول فجاز تأخيره كالنسخ والأدلة المنفصلة المخصصة للعموم.
الرابع: أن الاستثناء رافع لحكم اليمين فجاز تأخيره كالكفارة.
والجواب عن الخبر الأول أن سكوته قبل الاستثناء يحتمل أنه من السكوت الذي لا يخل بالاتصال الحكمي كما أسلفناه ويجب الحمل عليه موافقة لما ذكرناه من الأدلة.
وعن الخبر الثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم: " إن شاء الله " ليس عائداً إلى خبر الأول بل إلى ذكر ربه إذا نسي تقديره أذكر ربي إذا نسيت إن شاء الله وذلك كما إذا قال القائل لغيره: افعل كذا فقال: إن شاء الله أي أفعل إن شاء الله.
وعن المنقول عن ابن عباس إن صح ذلك فلعله كان يعتقد صحة إضمار الاستثناء ويدين المكلف بذلك فيما بينه وبين الله تعالى وإن تأخر الاستثناء لفظاً وهو غير ما نحن فيه وإن لم يكن كذلك فهو أيضاً مخصوم بما ذكرناه من الأدلة واتفاق أهل اللغة على إبطاله ممن سواه.
وعن الوجه الثالث أنه قياس في اللغة فلا يصح لما سبق ثم هو منقوض بالخبر والشرط كما سبق كيف والفرق بين التخصيص والاستثناء واقع من جهة الجملة من حيث إن التخصيص قد يكون بدليل العقل والحس ولا كذلك الاستثناء وبينه وبين النسخ أن النسخ مما يمتنع اتصاله بالمنسوخ بخلاف الاستثناء.
وعن الوجه الرابع بالفرق وهو أن الكفارة رافعة لإثم الحنث لا لنفس الحنث والاستثناء مانع من الحنث فما التقيا في الحكم حتى يصح قياس أحدهما على الآخر كيف وإن الخلاف إنما وقع في صحة الاستثناء المنفصل من جهة اللغة لا من جهة الشرع ولا قياس في اللغة على ما سبق.
المسألة الثانية اختلف العلماء في صحة الاستثناء من غير الجنس: فجوزه أصحاب أبي حنيفة ومالك والقاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين والنحاة ومنع منه الأكثرون.
وأما أصحابنا فمنهم من قال بالنفي ومنهم من قال بالإثبات احتج من قال بالبطلان بأن الاستثناء استفعال مأخوذ من الثني ومنه تقول: ثنيت الشيء إذا عطفت بعضه على بعض وثنيت فلاناً عن رأيه وثنيت عنان الفرس وحقيقته أنه استخراج بعض ما تناوله اللفظ وذلك غير متحقق في مثل قول القائل: رأيت الناس إلا الحمر لأن الحمر المستثناة غير داخلة في مدلول المستثنى منه حتى يقال بإخراجها وثنيها عنه بل الجملة الأولى باقية بحالها لم تتغير ولا تعلق للثاني بالأول أصلاً ومع ذلك فلا تحقق للاستثناء من اللفظ ولا يمكن أن يقال بصحة الاستثناء بناء على ما وقع به الاشتراك من المعنى بين المستثنى منه وإلا لصح استثناء كل شيء من كل شيء ضرورة أنه ما من شيئين إلا وهما مشتركان في معنى عام لهما وليس كذلك كيف وأنه لو قال القائل: جاء العلماء إلا الكلاب وقدم الحاج إلا الحمير كان مستهجناً لغة وعقلاً وما هذا شأنه لا يكون وضعه مضافاً إلى أهل اللغة.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الاستثناء مأخوذ من الثني بل من التثنية وكأن الكلام كان واحداً فثني وليس أحد الأمرين أولى من الآخر فإن قيل: لو كان الاستثناء مأخوذاً من التثنية لكان كل ما وجد فيه معنى التثنية من الكلام استثناء وليس كذلك.
قلنا: ولو كان مأخوذاً من الثني لكان كل ما وجد فيه الثني والعطف استثناء وليس كذلك ولهذا لا يقال لمن عطف الثوب بعضه على بعض أو عطف عنان الفرس إنه استثناء.
قولكم إن الاستثناء استخراج بعض ما تناوله اللفظ دعوى في محل النزاع وكيف يدعى ذلك مع قول الخصم بصحة الاستثناء من غير الجنس ولا دخول المستثنى تحت المستثنى منه وما ذكرتموه من الاستقباح لا يدل على امتناع صحته في اللغة ولهذا فإنه لو قال القائل في دعائه: يا رب الكلاب والحمير وخالقهم ارزقني وأعطني كان مستهجناً وإن كان صحيحاً من جهة اللغة والمعنى.
ثم وإن سلمنا امتناع صحة الاستثناء من نفس الملفوظ به مطابقة فما المانع من صحته نظراً إلى ما وقع به الاشتراك بين المستثنى والمستثنى منه في المعنى اللازم المدلول للفظ مطابقه كما قال الشافعي إنه لو قال القائل لفلان علي مائة درهم إلا ثوباً فإنه يصح ويكون معناه إلا قيمة ثوب لاشتراكهما في ثبوت صفة القيمة لهما وكما قاله أبو حنيفة في استثناء المكيل من الموزون وبالعكس لاشتراكهما في علة الربا.
قولكم: لو صح ذلك لصح استثناء كل شيء من كل شيء ليس كذلك وما المانع أن تكون صحة الاستثناء مشروطة بمناسبة بين المستثنى والمستثنى منه كما إذا قال القائل: ليس لي نخل إلا شجر ولا إبل إلا بقر ولا بنت إلا ذكر ولا كذلك فيما إذا قال: ليس لفلان بنت إلا أنه باع داره وأما القائلون بالصحة فقد احتجوا بالمنقول والمعقول: أما المنقول فمن جهة القرآن والشعر والنثر.
أما القرآن فقوله تعالى: " وإذ قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم " " البقرة 34 " " فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين " " الأعراف 11 " وإبليس لم يكن من جنس الملائكة لقوله تعالى في آية أخرى: " إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه " " الكهف 50 " والجن ليسوا من جنس الملائكة ولأنه كان مخلوقاً من نار على ما قال: " خلقتني من نار " " الأعراف 12 " والملائكة من نور ولأن إبليس له ذرية على ما قال تعالى: " أفتتخذونه وذريته أولياء " " الكهف 50 " ولا ذرية للملائكة فلا يكون من جنسهم وهو مستثنى منهم وقوله تعالى: " أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين " " الشعراء 75 " استثنى الباري تعالى من جملة ما كانوا يعبدون من الأصنام وغيرها والباري تعالى ليس من جنس شيء من المخلوقات
وقوله تعالى: " وما لهم به من علم إلا أتباع الظن " " النساء 157 " استثنى الظن من العلم وليس من جنسه وقوله تعالى: " لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً " " الواقعة 26 - 27 " استثنى السلام من اللغو وليس من جنسه وقوله تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " " النساء 29 " والتجارة ليست من جنس الباطل وقد استثناها منه وقوله تعالى: " فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا " " يس 43 " استثنى الرحمة من نفي الصريخ والإنقاذ وليست من جنسه وقوله تعالى: " لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم " " هود 43 " ومن رحم ليس بعاصم بل معصوم وليس المعصوم من جنس العاصم وقوله تعالى: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ " " النساء 92 " استثنى الخطأ من القتل وليس من جنسه.
وأما الشعر فمن ذلك قول القائل منهم:
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس
والعيس ليست من جنس الأنيس وقال النابغة الذبياني:
وقفت فيها أصيلالا أسائلها ... عيت جواباً وما بالربع من أحد
إلا أواري لأياً ما أبينها ... والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد
والأواري ليست من جنس الأحد وقال:
ولا عيب فيهم غير أن سيوفنا ... بهن فلول من قراع الكتائب
وليس فلول السيوف عيباً لأربابها بل فخراً لهم وقد استثناها من العيوب وليست من جنسها.
وأما النثر فقول العرب: ما زاد إلا ما نقص وما بالدار أحد إلا الوتد وما جاءني زيد إلا عمرو استثنوا النقص من الزيادة والوتد من أحد وعمراً من زيد وليس من جنسه.
وأما المعقول فهو أن الاستثناء لا يرفع جميع المستثنى منه فصح كاستثناء الدراهم من الدنانير وبالعكس.
ولقائل أن يقول: أما الآية الأولى فلا نسلم أن إبليس لم يكن من جنس الملائكة قولكم إنه كان من الجن قلنا: لا منافاة بين الأمرين: فإنه قد قال ابن عباس وغيره من المفسرين إن إبليس كان من الملائكة من قبيل يقال لهم الجن لأنهم كانوا خزان الجنان وكان إبليس رئيسهم وتسميته جنياً لنسبته إلى الجنة كما يقال بغدادي ومكي ويحتمل أنه سمي بذلك لاجتنانه واختفائه ويدل على كونه من الملائكة أمران: الأول أن الله تعالى استثناه من الملائكة والأصل أن يكون من جنسهم للاتفاق على صحة الاستثناء من الجنس ووقع الخلاف في غيره الثاني أن الأمر بالسجود لآدم إنما كان للملائكة بدليل قوله تعالى: " وإذ قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم " " البقرة 34 " ولو لم يكن إبليس من الملائكة لما كان عاصياً للأمر المتوجه إلى الملائكة لكونه ليس منهم إذ الأصل عدم أمر وراء ذلك الأمر ودليل عصيانه قوله تعالى: " إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين " " البقرة 34 " .
قولكم إن إبليس له ذرية ليس في ذلك ما ينافي كونه من جنس الملائكة فلئن قلتم بأن التوالد لا يكون إلا من ذكر وأنثى والملائكة لا إناث فيهم بدليل قوله تعالى: " وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً " " الزخرف 19 " ذكر ذلك في معرض الإنكار والتوعد على قول ذلك.
قلنا إنما يلزم من ذلك الإناث في الملائكة أن لو امتنع حصول الذرية إلا من جنسين وهو غير مسلم.
قولكم: إن إبليس مخلوق من نار والملائكة من نور لا منافاة أيضاً بين ذلك وبين كونه من الملائكة.
وأما الآية الثانية فاستثناء الرب تعالى فيها من المعبودين وذلك قوله: " ما كنتم تعبدون " " الشعراء 75 " وهم كانوا ممن يعبد الله مع الأصنام لأنهم كانوا مشركين لا جاحدين لله تعالى فلا يكون الاستثناء من غير الجنس.
وأما الآية الثالثة فجوابها من وجهين: الأول أن قوله تعالى: " وما لهم به من علم إلا اتباع الظن " " النساء 157 " عام في كل ما يسمى علماً والظن يسمى علماً ودليله قوله تعالى: " فإن علمتموهن مؤمنات " " الممتحنة 10 " وأراد إن ظننتموهن لاستحالة اليقين بذلك وذلك إن كان من الأسماء المتواطئة فلا يكون الاستثناء من غير الجنس وإن كان من الأسماء المشتركة أو المجازية فهو من جملة الأسماء العامة كما سبق.
الثاني أن إلا فيها ليست للاستثناء بل هي بمعنى لكن وكذلك الحكم فيما بعدها من الآيات.
وأما استثناء اليعافير والعيس من الأنيس فليس استثناء من غير الجنس لأنها مما يؤنس بها فهي من جنس الأنيس وإن لم تكن من جنس الأنس بل وقد يحصل الأنس بالآثار والأبنية والأشجار فضلاً عن الحيوان.
وأما استثناء الأواري من أحد فإنما كان لأنه كما يطلق الأحد على الآدمي فقد يطلق على غيره من الحيوانات والجمادات ولذلك يقال: رأيت أحد الحمارين وركبت أحد الفرسين ورميت أحد الحجرين وأحد السهمين فلم يكن الاستثناء من غير الجنس من حيث إن الأواري مما يصدق عليها لفظة أحد وبتقدير أن لا يكون من الجنس فإلا ليست استثنائية حقيقة بل بمعنى لكن كما سبق.
وأما فلول السيوف فهو عيب في السيوف وإن كان يسبب فلولها فخراً ومدحة لأربابها فهو في الجملة استثناء من الجنس.
وقول العرب: ما زاد إلا ما نقص تقديره: ما زاد شيء إلا الذي نقص أي ينقص وهو استثناء من الجنس.
وقولهم: ما في الدار أحد إلا الوتد فجوابه كما سبق في الأواري من أحد وقوله ما جاءني زيد إلا عمرو فإلا بمعنى لكن.
وما ذكروه من المعقول قولهم: إن الاستثناء لا يرفع جميع المستثنى منه فشيء لا إشعار له بصحة الاستثناء من غير الجنس.
وأما استثناء الدراهم من الدنانير ) وبالعكس فهو أيضاً محل النزاع عند القائلين بعدم صحة الاستثناء من غير الجنس وإن تكلف بيان صحة الاستثناء من جهة اشتراكهما في النقدية وجوهرية الثمنية فآئل إلى الاستثناء من الجنس.
المسألة الثالثة اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق كقوله له علي عشرة إلا عشرة وإنما اختلفوا في استثناء النصف والأكثر فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحة استثناء الأكثر حتى إنه لو قال: له علي عشرة إلا تسعة لم يلزمه سوى درهم واحد وذهب القاضي أبو بكر في آخر أقواله والحنابلة وابن درستويه النحوي إلى المنع من ذلك وزاد القاضي أبو بكر والحنابلة القول بالمنع من استثناء المساوي وقد نقل عن بعض أهل اللغة استقباح استثناء عقد صحيح فلا يقول: له علي مائة إلا عشرة بل خمسة أو غير ذلك احتج من قال بصحة استثناء الأكثر والمساوي بالمنقول والمعقول والحكم أما المنقول فمن جهة القرآن والشعر.
أما القرآن فقوله تعالى: " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين " " الحجر 42 " وقال: " لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين " " ص 83 " فإن استووا فقد استثنى المساوي وإن تفاوتوا فأيهما كان أكثر فقد استثناه كيف وإن الغاوين أكثر بدليل قوله تعالى: " وقليل من عبادي الشكور " " سبأ 13 " .
وقوله تعالى: " ولا تجد أكثرهم شاكرين " " الأعراف 17 " وقوله تعالى: " وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين " " يوسف 103 " ولكن أكثرهم " لا يعقلون " " القصص 13 " ولا يؤمنون.
وأما الشعر فقوله:
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكماً بالحق قوالا
وأما المعقول فهو أن الاستثناء لفظ يخرج من الجملة ما لولاه لدخل فيها فجاز إخراج الأكثر به كالتخصيص بالدليل المنفصل كاستثناء الأقل.
هذا ما يخص الأكثر وأما المساوي فدليله قوله تعالى: " يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه " " المزمل 1 " استثنى النصف وليس بأقل.
وأما الحكم فعام للأكثر والمساوي وهو أنه لو قال: له علي عشرة واستثنى منها خمسة أو تسعة فإنه يلزمه في الأول خمسة وفي الثاني درهم باتفاق الفقهاء ولولا صحة الاستثناء لما كان كذلك.
وفي هذه الحجج ضعف إذ لقائل أن يقول أما الآية فالغاوون فيها وإن كانوا أكثر من العباد المخلصين بدليل النصوص المذكورة فلا نسلم أن إلا في قوله: " إلا من اتبعك من الغاوين " " الحجر 42 " للاستثناء بل هي بمعنى لكن وإن سلمنا أنها للاستثناء ولكن نحن إنما نمنع من استثناء الأكثر إذا كان عدد المستثنى والمستثنى منه مصرحاً به كما إذا قال: له علي مائة إلا تسعة وتسعين درهماً وأما إذا لم يكن العدد مصرحاً به كما إذا قال له: خذ ما في الكيس من الدراهم سوى الزيوف منها فإنه يصح وإن كانت الزيوف في نفس الأمر أكثر في العدد وكما إذا قال: جاءني بنو تميم سوى الأوباش منهم فإنه يصح من غير استقباح وإن كان عدد الأوباش منهم أكثر.
وأما الشعر فلا استثناء فيه بل معناه: أدوا المائة التي سقط منها تسعون ولا يلزم أن يكون سقوطها بطريق الاستثناء.
وما ذكروه من المعقول فحاصله يرجع إلى القياس في اللغة وهو فاسد كما سبق كيف والفرق بين الأصل والفرع واقع من جهة الإجمال أما التخصيص فمن جهة أنه قد يكون بدليل منفصل وبغير دليل لفظي كما يأتي.
وأما استثناء الأقل فلكونه غير مستقبح كما إذا قال: له علي عشرة إلا درهماً ولا كذلك قوله: له علي مائة إلا تسعة وتسعين.
وأما قوله تعالى: " يا أيها المزمل " " المزمل 1 " فلا دلالة فيه على جواز استثناء النصف إذ النصف غير مستثنى وإنما هو ظرف للقيام فيه وتقديره قم الليل ونصفه إلا قليلاً.
وأما الحكم فدعوى الاتفاق عليه خطأ فإن من لا يرى صحة استثناء الأكثر والمساوي فهو عنده بمنزلة الاستثناء المستغرق ولو قال: له علي عشرة إلا عشرة لزمه العشرة وإنما ذهب إلى ذلك الفقهاء القائلون بصحة استثناء الأكثر والمساوي.
وأما من قال بامتناع صحة استثناء الأكثر والمساوي فقد احتج بأن الاستثناء على خلاف الأصل لكونه إنكاراً بعد إقرار وجحداً بعد اعتراف غير أنا خالفناه في استثناء الأقل لمعنى لم يوجد في المساوي والأكثر فوجب أن لا يقال بصحته فيه وبيان ذلك من وجهين: الأول: أن المقر ربما أقر بمال وقد وفى بعضه غير أنه نسيه لقلته وعند إقراره ربما تذكره فاستثناه فلو لم يصح استثناؤه لتضرر ولا كذلك في الأكثر والنصف لأنه قلما يتفق الذهول عنه.
والثاني: أنه إذا قال: له علي مائة إلا درهماً لم يكن مستقبحاً وإذا قال له علي مائة إلا تسعة وتسعين كان مستقبحاً والمستقبح في لغة العرب لا يكون من لغتهم.
وهذه الحجة ضعيفة أيضاً إذ لقائل أن يقول: لا نسلم أن الاستثناء على خلاف الأصل والقول بأنه إنكار بعد إقرار إنما يصح ذلك أن لو لم يكن المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة وإلا فلا وإن سلمنا عدم الاتحاد ولكن لا نسلم مخالفة ذلك الأصل بل الأصل قبوله لإمكان صدق المتكلم به ودفعاً للضرر عنه ويجب اعتقاد ذلك حتى لا يكون قبول ذلك في استثناء الأقل على خلاف الأصل والقول بأن ذلك مستقبح ركيك في لغة العرب ليس فيه ما يمنع مع ذلك من استعماله ولهذا فإنه لو قال: له علي عشرة إلا درهماً كان مستحسناً ولو قال: له علي عشرة إلا دانقاً ودانقاً إلى تمام عشرين مرة كان في غاية الاستقباح وما منع ذلك من صحته واستعماله لغة.
المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء رجع إلى جميعها عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة.
وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة: إن كان الشروع في الجملة الثانية إضراباً عن الأولى ولا يضمر فيها شيء مما في الأولى فالاستثناء مختص بالجملة الأخيرة لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى مع استقلالها بنفسها إلى غيرها إلا وقد تم مقصوده منها وذلك على أقسام أربعة: القسم الأول: أن تختلف الجملتان نوعا كما لو قال أكرم بني تميم والنحاة البصريون إلا البغاددة إذ الجملة الأولى أمر والثانية خبر.
القسم الثاني: أن تتحدا نوعاً وتختلفا اسماً وحكماً كما لو قال: أكرم بني تميم واضرب ربيعة إلا الطوال إذ هما أمران.
القسم الثالث: أن تتحدا نوعاً وتشتركا حكماً لا اسماً كما لو قال: سلم على بني تميم وسلم على بني ربيعة إلا الطوال.
القسم الرابع: أن تتحدا نوعاً وتشتركا اسماً لا حكماً ولا يشترك الحكمان في غرض من الأغراض كما لو قال: سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال.
وأقوى هذه الأقسام في اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة القسم الأول ثم الثاني ثم الثالث والرابع.
وأما إن لم تكن الجملة الأخيرة مضربة عن الأولى بل لها بها نوع تعلق فالاستثناء راجع إلى الكل وذلك أربعة أقسام.
القسم الأول: أن تتحد الجملتان نوعاً واسماً لا حكماً غير أن الحكمين قد اشتركا في غرض واحد كما لو قال: أكرم بني تميم وسلم على بني تميم إلا الطوال لاشتراكهما في غرض الإعظام.
القسم الثاني: أن تتحد الجملتان نوعاً وتختلفا حكماً واسم الأولى مضمر في الثانية كما لو قال أكرم بني تميم واستأجرهم وربيعة إلا الطوال.
القسم الثالث: بالعكس من الذي قبله كما لو قال: أكرم بني تميم وربيعة إلا الطوال.
القسم الرابع: أن يختلف نوع الجمل المتعاقبة إلا انه قد أضمر في الجملة الأخيرة ما تقدم أو كان غرض الأحكام المختلفة فيها واحدا كما في آية القذف فإن جملها مختلفة النوع من حيث إن قوله تعالى: " فاجلدوهم ثمانين جلدة " " النور 4 " أمر وقوله: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً " " النور 4 " نهي وقوله " وأولئك هم الفاسقون " " النور 4 " خبر غير أنها داخلة تحت القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة لاشتراك أحكام هذه الجمل في غرض الانتقام والإهانة وداخلة تحت القسم الثاني من جهة إضمار الاسم المتقدم فيها.
وذهب المرتضى من الشيعة إلى القول بالاشتراك وذهب القاضي أبو بكر والغزالي وجماعة من الأصحاب إلى الوقف.
والمختار انه مهما ظهر كون الواو للابتداء فالاستثناء يكون مختصاً بالجملة الأخيرة كما في القسم الأول من الأقسام الثانية المذكورة لعدم تعلق إحدى الجملتين بالأخرى وهو ظاهر وحيث أمكن أن تكون الواو للعطف أو الابتداء كما في باقي الأقسام السبعة فالواجب إنما هو الوقف.
وتحقيق ذلك متوقف على ذكر حجج المخالفين وإبطالها ولنبدأ من ذلك بحجج القائلين بالعود إلى الجميع: الحجة الأولى: أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة ولهذا فإنه لا فرق في اللغة بين قوله: اضرب الجماعة التي منها قتلة وسراق وزناة إلا من تاب وبين قوله: اضرب من قتل وسرق وزنا إلا من تاب فوجب اشتراكهما في عود الاستثناء إلى الجميع وهي غير صحيحة وذلك لأنه إن قيل إنه لا فارق بين الجملة والجملتين في أمر ما لزم أن يكون المتكثر واحدا والواحد متكثراً وهو محال وإن قيل بالفرق فلا بد من جامع موجب للاشتراك في الحكم ومع ذلك فحاصله يرجع إلى القياس في اللغة ولا سبيل إليه لما تقدم.
الحجة الثانية: أن الإجماع منعقد على أنه لو قال: والله لا أكلت الطعام ولا دخلت الدار ولا كلمت زيداً واستثنى بقوله: إن شاء الله أنه يعود إلى الجميع وهذه الحجة أيضاً باطلة فإن العلماء وإن أطلقوا لفظ الاستثناء على التعليق على المشيئة فمجاز وليس باستثناء حقيقة بل ذلك شرط كما في قوله: إن دخلت الدار ويدل على كونه شرطاً لا استثناء أنه يجوز دخوله على الواحد مع أن الواحد لا يدخله الاستثناء وذلك كقوله: أنت طالق إن شاء الله ولو قال: أنت طالق طلقة إلا طلقة لم يصح ووقع به طلقة وكذلك إذا قال له: علي درهم إلا درهماً وإذا كان شرطاً فلا يلزم من عوده إلى الجميع عود الاستثناء إلا بطريق القياس ولا بد من جامع مؤثر ومع ذلك يكون قياساً في اللغة وهو باطل بما سبق وبهذا يبطل إلحاقهم الاستثناء بالشرط وهو قولهم الاستثناء غير مستقل بنفسه فكان عائداً إلى الكل كالشرط وهو ما إذا قال أكرم بني تميم وبني ربيعة إن دخلوا الدار ولو صرح بذلك كان صحيحاً ولا كذلك في الاستثناء ولهذا فإنه لو قال: إلا أن يتوبوا اضرب بني تميم وبني ربيعة لا يكون صحيحاً.
الحجة الثالثة: أن الحاجة قد تدعو إلى الاستثناء من جميع الجمل وأهل اللغة مطبقون على أن تكرار الاستثناء في كل جملة مستقبح ركيك مستثقل وذلك كما لو قال: إن دخل زيد الدار فاضربه إلا أن يتوب وإن زنا فاضربه إلا أن يتوب فلم يبق سوى تعقب الاستثناء للجملة الأخيرة.
ولقائل أن يقول: وإن كان ذلك مطولاً غير أنه يعرف شمول الاستثناء للكل بيقين فلا يكون مستقبحاً وإن كان مستقبحاً فإنما يمتنع أن لو كان وضع اللغة مشروطاً بالمستحسن وهو غير مسلم ودليله أنه لو وقع الاستثناء كذلك فإنه يصح لغة ويثبت حكمه ولولا أنه من وضع اللغة لما كان كذلك.
الحجة الرابعة: إن الاستثناء صالح أن يعود إلى كل واحدة من الجمل وليس البعض أولى من البعض فوجب العود إلى الجميع كالعام.
ولقائل أن يقول: كونه صالحاً للعود إلى الجميع غير موجب لذلك ولهذا فإن اللفظ إذا كان حقيقة في شيء ومجازاً في شيء فهو صالح للحمل على المجاز ولا يجب حمله على المجاز.
وما ذكروه من الإلحاق بالعموم فغير صحيح لما علم مراراً.
الحجة الخامسة: أنه لو قال علي خمسة وخمسة إلا ستة فإنه يصح ولو كان مختصاً بالجملة الأخيرة لما صح لكونه مستغرقاً لها.
قلنا: لا نسلم صحة الاستثناء على رأي لنا وإن سلمنا فإنما عاد إلى الجميع لقيام الدليل عليه وذلك لأنه لا بد من إعمال لفظه مع الإمكان وقد تعذر استثناء الستة من الجملة الأخيرة لكونه مستغرقاً لها وهو صالح للعود إلى الجميع فحمل عليه ومع قيام الدليل على ذلك فلا نزاع وإنما النزاع فيما إذا ورد الاستثناء مقارناً للجملة الأخيرة من غير دليل يوجب عوده إلى ما تقدم.
الحجة السادسة: أنه لو قال القائل: بنو تميم وربيعة أكرموهم إلا الطوال فإن الاستثناء يعود إلى الجميع فكذلك إذا تقدم الأمر بالإكرام ضرورة اتحاد المعنى.
ولقائل أن يقول: حاصل ما ذكروه يرجع إلى القياس في اللغة وهو باطل لما علم كيف والفرق ظاهر لأنه إذا تأخر الأمر عن الجمل فقد اقترن باسم الجميع وهو قوله أكرموهم بخلاف الأمر المتقدم فإنه لم يتصل باسم الفريقين بل باسم الفريق الأول.
الحجة السابعة: أنه إذا قال القائل: اضربوا بني تميم وبني ربيعة إلا من دخل الدار فمعناه من دخل من الفريقين ولقائل أن يقول ليس تقدير هذا المعنى أولى من تقدير إلا من دخل من ربيعة.
وأما حجج القائلين بعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فمن جهة النص والمعقول.
أما النص فقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا " " النور 4 " فإنه راجع إلى قوله وأولئك هم الفاسقون ولم يرجع إلى الجلد بالاتفاق وأيضاً قوله تعالى: " فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " " النساء 92 " وقوله " إلا أن يصدقوا " " النساء 92 " راجع إلى الدية دون الإعتاق بالاتفاق.
قلنا: أما الآية الأولى فلا نسلم اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة منها بل هو عائد إلى جميع الجمل عدا الجلد لدليل دل عليه وهو المحافظة على حق الآدمي.
أما الآية الأخرى فإنما امتنع عود الاستثناء إلى الإعتاق لأنه حق الله تعالى وتصدق الولي لا يكون مسقطاً لحق الله تعالى: وأما من جهة المعقول فحجج: الحجة الأولى أن الاستثناء من الجملة إذا تعقبه استثناء كان الاستثناء الثاني عائداً إلى الجملة الاستثنائية لا إلى الجملة الأولى فدل على اختصاص الاستثناء بالجملة المقارنة دون المتقدمة وإلا كان عدم عوده إلى المتقدمة على خلاف الأصل وذلك كما لو قال له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين فإن الاستثناء الثاني يختص بالأربعة دون العشرة.
ولقائل أن يقول: الاستثناء الثاني إما أن يكون بحرف عطف أو لا بحرف عطف فإن كان الأول فهو راجع إلى الجملة المستثني منها كقوله: له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين فيكون المقر به خمسة وإن كان الثاني كقوله: له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين فإنما امتنع عوده إلى الجملة المستثني منها لدليل لا لعدم اقتضائه لذلك لغة وذلك أن الاستثناء الثاني لو عاد إلى الجملة المستثني منها فإما أن يعود إليها لا غير أو إليها وإلى الاستثناء: الأول ممتنع لأن الإجماع منعقد على دخول الاستثناء الأول تحت الاستثناء الثاني فقطعه عنه ورده إلى الجملة المستثنى منها لا غير يكون على خلاف الإجماع وإن كان عائداً إلى الاستثناء والمستثنى منه فالمستثنى منه إثبات فالاستثناء منه يكون نفياً لأن الاستثناء من الإثبات نفي والاستثناء من الاستثناء يكون إثباتاً لأن الاستثناء من النفي إثبات على ما يأتي تقريره عن قريب وذلك ممتنع لوجهين: الوجه الأول: أنه يلزم منه أن يكون قد أثبت لعوده إلى أحدهما مثل ما نفاه عن الآخر ويكون جابراً للنفي بالإثبات ويبقى ما كان متحققاً قبل الاستثناء الثاني بحاله وفيه إلغاء الاستثناء الثاني وخروجه عن التأثير وهو خلاف الإجماع.
الوجه الثاني: أنه يلزم منه أن يكون بعوده إلى الجملة الأولى قد نفي عنها مثل ما أثبته لها بعوده إلى الاستثناء الثاني فيكون الاستثناء الواحد مقتضياً لنفي شيء وإثباته بالنسبة إلى شيء واحد وهو محال.
الحجة الثانية: أن الجملة الأخيرة حائلة بين الاستثناء والجملة الأولى فكان ذلك مانعاً من العود إليها كالسكوت.
ولقائل أن يقول: إنما يصح ذلك أن لو لم يكون الكلام كله بمنزلة جملة واحدة وأما إذا كان كالجملة الواحدة فلا.
الحجة الثالثة: أنه استثناء تعقب جملتين فلا يكون بظاهره عائداً إليهما كما لو قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعة فأنه لا يعود إلى الجميع وإلا لوقع به طلقتان لا ثلاث طلقات.
قلنا: لا نسلم امتناع عوده إلى الجميع بل هو عائد إلى الجميع والواقع طلقتان على رأي لنا وإن سلمنا امتناع عوده إلى الجميع فلأن المعتبر من قوله ثلاثاً وثلاثاً إنما هو الجملة الأولى دون الثانية فلو عاد الاستثناء إليها لكان مستغرقاً وهو باطل.
الحجة الرابعة: أن دخول الجملة الأولى تحت لفظه معلوم ودخولها تحت الاستثناء مشكوك فيه والشك لا يرفع اليقين.
قلنا: لا نسلم تيقن دخوله مع اتصال الاستثناء بالكلام ثم وإن كان ذلك مما يمنع من عود الاستثناء إلى الجمل المتقدمة فهو مانع من اختصاصه بالجملة الأخيرة لجواز عوده بالدليل إلى الجملة المتقدمة دون المتأخرة ثم يلزم منه أن لا يعود الشرط والصفة على باقي الجمل لما ذكروه وهو عائد عند أكثر القائلين باختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة.
الحجة الخامسة: أنه لما كان الاستثناء مما تدعو الحاجة إليه ولا يستقل بنفسه دعت الحاجة إلى عوده إلى غيره وهذه الحاجة والضرورة مندفعة بعوده إلى ما يليه فلا حاجة إلى عوده إلى غيره إذ هو خارج عن محل الحاجة وإنما وجب اختصاصه بما يليه دون غيره لوجهين.
الأول: أنه إذا ثبت اختصاصه بجملة واحدة وجب عوده إلى ما يليه لامتناع عوده إلى غيره بالإجماع.
الثاني: أنه قريب منه والقرب مرجح ولهذا وجب عود الضمير في قولهم: جاء زيد وعمرو أبوه منطلق إلى عمرو لكونه أقرب مذكور فكان ما يلي الفعل من الاسمين اللذين لا يظهر فيهما الإعراب بالفاعلية أولى كقولهم: ضربت سلمى سعدى وهذه الحجة أيضاً مدخولة إذ لقائل أن يقول ما ذكرتموه إنما يصح أن لو لم تكن الحاجة ماسة إلى عود الاستثناء إلى كل ما تقدم وذلك غير مسلم وإذا كانت الحاجة ماسة إلى عوده إلى كل ما تقدم فلا تكون الحاجة مندفعة بعوده إلى ما يليه فقط.
ثم ما ذكرتموه منتقض بالشرط والصفة وإن سلمنا أنه لا ضرورة ولكن لم قلتم بامتناع عوده إلى ما تقدم وإن لم تكن ثم ضرورة ولهذا فإنه لو قام دليل على إرادة عوده إلى الجميع فإنه يكون عائداً إليه إجماعاً وإنما الخلاف في كونه حقيقة في الكلام أم لا.
الحجة السادسة: ذكرها القلانسي وهي أن قال: نصب ما بعد الاستثناء في الإثبات إنما كان بالفعل المتقدم بإعانة إلا على ما هو مذهب أكابر البصريين فلو قيل إن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل لكان ما بعد إلا منتصباً بالأفعال المقدرة في كل جملة ويلزم منه اجتماع عاملين على معمول واحد وذلك لا يجوز لأنه بتقدير مضادة أحد العاملين في عمله للعامل الآخر يلزم منه أن يكون المعمول الواحد مرفوعاً منصوباً معاً وذلك كما لو قلت: ما زيد بذاهب ولا قام عمرو وهو محال ولأنه إما أن يكون كل واحد مستقلاً بالأعمال أولاً كل واحد منهما مستقل أو المستقل البعض دون البعض فإن كان الأول لزم من ذلك عدم استقلال كل واحد ضرورة أنه لا معنى لكون كل واحد مستقلاً إلا أن الحكم ثبت به دون غيره وإن كان الثاني فهو خلاف الفرض وإن كان الثالث فليس البعض أولى من البعض.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه إذا قال: قام القوم إلا زيداً أن زيداً منصوب بقام وإن سلمنا أنه منصوب بقام لكن بالفعل المحقق أو المقدر في كل جملة الأول مسلم والثاني ممنوع والفعل المحقق غير زائد على واحد وأم حجج القائلين بالاشتراك فثلاث: الحجة الأولى: أنه يحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة عود الاستثناء إلى ما يليه أو إلى الكل ولو كان حقيقة في أحد هذه المحامل دون غيره لما حسن ذلك وذلك يدل على الاشتراك وهذه الحجة مدخولة لجواز أن يكون الاستفهام لعدم المعرفة بالمدلول الحقيقي والمجازي أصلاً كما تقوله الواقفية أو لأنه حقيقة في البعض مجاز في البعض والاستفهام للحصول على اليقين ودفع الاحتمال البعيد كما بيناه فيما تقدم.
الحجة الثانية: أنه يصح إطلاق الاستثناء وإرادة عوده إلى ما يليه وإلى الجمل كلها وإلى بعض الجمل المتقدمة دون البعض بإجماع أهل اللغة والأصل في الإطلاق الحقيقة والمعاني مختلفة فكان مشتركاً.
ولقائل أن يقول: متى يكون الأصل في الإطلاق الحقيقة إذا أفضى إلى الاشتراك المخل بمقصود أهل الوضع من وضعهم أو إذا لم يفض؟ الأول ممنوع والثاني مسلم ثم وإن كان ذلك هو الأصل مطلقاً غير أنه أمر ظني ولم قلتم بإمكان التمسك به فيما نحن فيه على ما هو معلوم من قاعدة الواقفية.
الحجة الثالثة: أن الاستثناء فضلة لا تستقل بنفسها فكان احتمال عوده إلى ما يليه وإلى جميع الجمل مساوياً كالحال وظرف الزمان والمكان في قوله: ضربت زيداً وعمراً قائماً في الدار يوم الجمعة.
ولقائل أن يقول: لا نسلم صحة ما ذكره في الحال والظرف بل هو عائد إلى الكل أو ما يليه على اختلاف المذهبين وإن سلم ذلك غير أنه آئل إلى القياس في اللغة وهو باطل كما سبق.
المسألة الخامسة مذهب أصحابنا أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات خلافاً لأبي حنيفة.
ودليلنا في ذلك أن القائل إذا قال: لا إله إلا الله كان موحداً مثبتاً للألوهية لله سبحانه وتعالى ونافياً لها عما سواه ولو كان نافياً للألوهية عما سوى الرب تعالى غير مثبت لها بالنسبة إلى الرب تعالى لما كان ذلك توحيداً لله تعالى لعدم إشعار لفظه بإثبات الألوهية لله تعالى وذلك خلاف الإجماع.
وأيضاً فإنه إذا قال القائل: لا عالم في البلد إلا زيد كان ذلك من أدل الألفاظ على علم زيد وفضيلته وكان ذلك متبادراً إلى فهم كل سامع لغوي ولو كان نافياً للعلم عما سوى زيد غير مثبت للعلم لزيد لما كان كذلك وعلى هذا النحو في كل ما هو من هذا القبيل.
فإن قيل: لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً لكان قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي ولا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء " مقتضياً تحقق الصلاة عند وجود الطهور والنكاح عند وجود الولي والبيع عند المساواة ولما لم يكن كذلك علم أن المراد بالاستثناء إخراج المستثنى عن دخوله في المستثنى منه وأنه غير متعرض لنفيه ولا إثباته.
قلنا: الطهور والولي والمساواة لا يصدق عليه اسم ما استثني منه فكان استثناء من غير الجنس وهو باطل بما تقدم وإنما سبق ذلك لبيان اشتراط الطهور في الصلاة والولي في النكاح والمساواة في صحة بيع البر بالبر والشرط وإن لزم من فواته فوات المشروط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط لجواز انتفاء المقتضي أو فوات شرط آخر أو وجود مانع والله أعلم.
النوع الثاني التخصيص بالشرط والنظر في حده وأقسامه وصيغ الشرط اللغوي وأحكامه أما حده قال الغزالي: هو ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده وهو فاسد من وجهين: الأول أن فيه تعريف الشرط بالمشروط والمشروط مشتق من الشرط فكان أخفى من الشرط وتعريف الشيء بما هو أخفى منه ممتنع.
الثاني: أنه يلزم عليه جزء السبب إذا اتحد فإنه لا يوجد الحكم دونه ولا يلزم من وجود الحكم عند وجوده وليس بشرط.
وقال بعض أصحابنا: الشرط هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في ذاته وهو فاسد أيضاً فإن الحياة القديمة شرط في وجود علم الباري تعالى وكونه عالماً ولا تأثير ولا مؤثر.
والحق في ذلك أن يقال: الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سبباً لوجوده ولا داخلاً في السبب.
ويدخل في هذا الحد شرط الحكم وهو ظاهر وشرط السبب من حيث إنه يلزم من نفي شرط السبب انتفاء السبب وليس هو سبب السبب ولا جزؤه وفيه احتراز عن انتفاء الحكم لانتفاء مداركه وعن انتفاء المدرك المعين وجزئه وهو منقسم إلى شرط عقلي كالحياة للعلم والإرادة وإلى شرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم وإلى لغوي وصيغه كثيرة وهي: إن الخفيفة وإذا ومن ومهما وحيثما وأينما وإذ ما.
وأم هذه الصيغ إن الشرطية لأنها حرف وما عداها من أدوات الشرط أسماء والأصل في إفادة المعاني للأسماء إنما هو الحروف ولأنها تستعمل في جميع صور الشرط بخلاف أخواتها فإن كل واحدة منها تختص بمعنى لا تجري في غيره: فمن لمن يعقل وما لما لا يعقل وإذا لما لا بد من وقوعه كقولك: إذا احمر البسر فأتنا ونحو ذلك.
وأما أحكامه فمنها أنه يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه وذلك ضربان:
الأول: أن يخرج منه ما علمنا خروجه بدليل آخر كقوله: أكرم بني تميم إن دخلوا الدار فإنه يخرج من الكلام حالة عدم الاستطاعة وإن كان ذلك معلوما دون قوله فيكون قوله مؤكداً.
الثاني: أنه يخرج منه ما لا يعلم خروجه دونه كقوله: أكرم بني تميم إن دخلوا الدار فإنه يخرج منه حالة عدم دخول الدار ولولا الشرط لعم الإكرام جميع الأحوال ولم يكن العلم بعدم الإكرام حالة عدم دخول الدار حاصلاً لنا فكان مخصصاً للعموم.
وعلى كل تقدير لا يخلو إما أن يتحد الشرط والمشروط أو يتعدد المشروط أو بالعكس أو يتعددان معاً فإن اتحد الشرط والمشروط فمثاله ما سبق.
وأما إن اتحد الشرط وتعدد المشروط فإما أن تكون المشروطات على الجمع أو على البدل: فإن كانت على الجمع كقوله: إن دخل زيد الدار فأعطه ديناراً ودرهماً وإن كانت على البدل كقوله إن دخل زيد الدار فأعطه ديناراً أو درهماً فالحكم كما لو اتحد المشروط.
وأما إن تعدد الشرط واتحد المشروط فإما أن تكون الشروط على الجمع أو البدل: فإن كان الأول فكقوله: أكرم بني تميم أبداً إن دخلوا الدار والسوق فمقتضى ذلك توقف الإكرام على اجتماع الشرطين واختلاله باختلال أحدهما وإن كان على البدل كقوله: أكرم بني تميم إن دخلوا السوق أو الدار فمقتضى ذلك توقف الإكرام على تحقق أحد الشرطين واختلاله عند اختلالهما جميعاً.
وأما إن تعدد الشرط والمشروط فإما أن يكون الشرط والمشروط على الجمع أو البدل أو الشرط على الجمع والمشروطات على البدل أو بالعكس: فإن كان القسم الأول كقوله: إن دخل زيد الدار والسوق فأعطه درهماً وديناراً فالإعطاء متوقف على اجتماع الشرطين ومختل باختلالهما أو باختلال أحدهما وإن كان القسم الثاني فكقوله: إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درهماً أو ديناراً فإعطاء أحد الأمرين متوقف على تحقق أحد الشرطين واختلاله باختلال مجموع الأمرين.
وإن كان القسم الثالث كقوله: إن دخل زيد الدار والسوق فأعطه درهماً أو ديناراً فإعطاء أحد الأمرين متوقف على اجتماع الشرطين واختلاله باختلال أحدهما.
وإن كان الرابع كقوله: إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درهماً وديناراً فإعطاء الأمرين متوقف على أحد الشرطين ومختل باختلالهما معاً وسواء كان حصول الشرط دفعة أو لا دفعة بل شيئاً فشيئاً.
ومن أحكامه أنه لا بد من اتصاله بالمشروط لما تقدم في الاستثناء وأنه يجوز تقديمه على المشروط وتأخيره وإن كان الوضع الطبيعي له إنما هو صدر الكلام والتقدم على المشروط لفظاً لكونه متقدماً عليه في الوجود طبعاً ولو تعقب الشرط للجمل المتعاقبة فقد اتفق الشافعي وأبو حنيفة على عوده إلى جميعها خلافاً لبعض النحاة في اعتقاده اختصاصه بالجملة التي تليه كانت متقدمة أو متأخرة والكلام في الطرفين فعلى ما سبق في الاستثناء والمختار كالمختار ولا يخفى وجهه.
النوع الثالث تخصيص العام بالصفة وهي لا تخلو إما أن تكون مذكورة عقب جملة واحدة أو جمل: فإن كان الأول كقوله أكرم بني تميم الطوال فإنه يقتضي اختصاص الإكرام بالطوال منهم ولولا ذلك لعم الطوال والقصار فكانت الصفة مخرجة لبعض ما كان داخلاً تحت اللفظ لولا الصفة.
وإن كان الثاني كقوله أكرم بني تميم وبني ربيعة الطوال فالكلام في عود الصفة إلى ما يليها أو إلى الجميع كالكلام في الاستثناء.
النوع الرابع التخصيص بالغاية وصيغها إلى وحتى ولا بد وأن يكون حكم ما بعدها مخالفاً لما قبلها وإلا كانت الغاية وسطاً وخرجت عن كونها غاية ولزم من ذلك إلغاء دلالة إلى وحتى وهي لا تخلو أيضاً إما أن تكون مذكورة عقب جملة واحدة أو جمل متعددة فإن كان الأول فإما أن تكون الغاية واحدة أو متعددة.
فإن كانت واحدة كقوله: أكرم بني تميم أبداً إلى أن يدخلوا الدار فإن دخول الدار يقتضي اختصاص الإكرام بما قبل الدخول وإخراج ما بعد الدخول عن عموم اللفظ ولولا ذلك لعم الإكرام حالة ما بعد الدخول.
وإن كانت متعددة فلا يخلو إما أن تكون على الجمع أو على البدل: فالأول كقوله أكرم بني تميم أبداً إلى أن يدخلوا الدار ويأكلوا الطعام فمقتضى ذلك استمرار الإكرام إلى تمام الغايتين دون ما بعدهما والثاني كقوله أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا الدار أو السوق فمقتضى ذلك استمرار الإكرام إلى انتهاء إحدى الغايتين أيهما كانت دون ما بعدها.
وأما إن كانت الغاية مذكورة عقب جمل متعددة فالكلام في اختصاصها بما يليها وفي عودها إلى جميع الجمل كالكلام في الاستثناء وسواء كانت الغاية واحدة أو متعددة على الجمع أو البدل ولا تخفى أمثلتها ووجه الكلام فيها وسواء كانت الغاية معلومة الوقوع في وقتها كقوله إلى أن تطلع الشمس أو غير معلومة الوقت كقوله إلى دخول الدار.
القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة وفيه أربع عشرة مسألة.
المسألة الأولى مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي خلافاً لطائفة شاذة من المتكلمين.
ودليل ذلك أن قوله تعالى: " الله خالق كل شيء " " الزمر 62 " وقوله: " وهو على كل شيء قدير " " هود 4 " متناول بعموم لفظه لغة كل شيء مع أن ذاته وصفاته أشياء حقيقة وليس خالقاً لها ولا هي مقدورة له لاستحالة خلق القديم الواجب لذاته واستحالة كونه مقدوراً بضرورة العقل فقد خرجت ذاته وصفاته بدلالة ضرورة العقل عن عموم اللفظ وذلك مما لا خلاف فيه بين العقلاء ولا نعني بالتخصيص سوى ذلك فمن خالف في كون دليل العقل مخصصاً مع ذلك فهو موافق على معنى التخصيص ومخالف في التسمية وكذلك قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " " آل عمران 97 " فإن الصبي والمجنون من الناس حقيقة وهما غير مزادين من العموم بدلالة نظر العقل على امتناع تكليف من لا يفهم ولا معنى للتخصيص سوى ذلك.
فإن قيل نحن لا ننكر أن ذات الباري تعالى وصفاته وأن الصبي والمجنون مما لم يرد باللفظ وإنما ننكر كون دليل العقل مخصصاً لثلاثة أوجه.
الأول: أن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه وهو غير متصور فيما ذكرتموه وبيانه أن دلالات الألفاظ على المعاني ليست لذواتها وإلا كانت دالة عليها قبل المواضعة وإنما دلالتها تابعة لمقصد المتكلم وإرادته ونحن نعلم بالضرورة أن المتكلم لا يريد بلفظه الدلالة على ما هو مخالف لصريح العقل فلا يكون لفظه دالاً عليه لغة ومع عدم الدلالة اللغوية على الصورة المخرجة لا يكون تخصيصاً.
الثاني: أن التخصيص بيان والمخصص مبين والبيان إنما يكون بعد سابقة الإشكال فيجب أن يكون البيان متأخراً عن المبين ودليل العقل سابق فلا يكون مبيناً ولا مخصصاً كالاستثناء المقدم.
الثالث: أن التخصيص بيان فلا يجوز بالعقل كالنسخ ثم وإن سلمنا دلالة اللفظ لغة على ما ذكرتموه وجواز كون المخصص متقدماً ولكن ما المانع أن تكون صحة الاحتجاج بالدليل العقلي مشروطة بعدم معارضة عموم الكتاب له وبتقدير الاشتراط بذلك لا يكون حجة في التمسك به على الكتاب وإن سلمنا صحة التخصيص في الآيتين المذكورتين أولاً ولكن لا نسلم صحة تخصيص الصبي والمجنون عن عموم آية الحج فإن ما ذكرتموه مبني على امتناع خطابهما وكيف يمكن دعوى ذلك مع دخولهما تحت الخطاب بأروش الجنايات وقيم المتلفات وإجماع الفقهاء على صحة صلاة الصبي واختلافهم في صحة إسلامه ولولا إمكان دخوله تحت الخطاب لما كان كذلك.
والجواب عن الأول: قولهم إن دلالات الألفاظ ليست لذواتها مسلم وأنه لا بد في دلالتها من قصد الواضع لها دالة على المعنى.
قولهم: العاقل لا يقصد بلفظة الدلالة على ما هو ممتنع بصريح العقل قلنا: ذلك ممتنع بالنظر إلى ما وضع اللفظ عليه لغة أو بالنظر إلى إرادته من اللفظ؟ الأول ممنوع والثاني مسلم وعند ذلك فلا منافاة بين كون اللفظ دالاً على المعنى لغة وبين كونه غير مراد من اللفظ.
قولهم إن حق المخصص أن يكون متأخراً عما خصصه قلنا: يجب أن يكون متأخراً بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى صفته وهو كونه مبيناً ومخصصاً الأول ممنوع والثاني مسلم وذلك لأن دليل العقل وإن كان متقدماً في ذاته على الخطاب المفروض غير أنه لا يوصف قبل ذلك بكونه مخصصاً لما يوجد وإنما يصير مخصصاً ومبيناً بعد وجود الخطاب وأما الاستثناء فإنما لم يجز تقديمه لأن المتكلم به لا يعد متكلماً بكلام أهل اللغة كما إذا قال إلا زيداً ثم قال بعد ذلك قام القوم وهذا بخلاف التخصيص فإنه إذا قال: " الله خالق كل شيء " وقام الدليل العقلي على أنه لم يرد بكلامه ذات الباري تعالى فإنه لا يخرج بذلك الكلام عن كونه متكلماً بكلام العرب.
وأما امتناع النسخ بالعقل فإنما كان من جهة أن الناسخ معرف لبيان مدة الحكم المقصودة في نظر الشارع وذلك ما لا سبيل إلى الاطلاع عليه بمجرد العقل بخلاف معرفة استحالة كون ذات الرب تعالى مخلوقة مقدورة.
قولهم: ما المانع أن يكون التمسك بدليل العقل مشروطاً بعدم معارضة الكتاب له قلنا: إذا وقع التعارض بينهما وأحدهما مقتض للإثبات والآخر للنفي فلا سبيل إلى الجمع بين موجبيهما لما فيه من التناقض ولا إلى نفيهما لما فيه من وجود واسطة بين النفي والإثبات فلم يبق إلا العمل بأحدهما والعمل بعموم اللفظ مما يبطل دلالة صريح العقل بالكلية وهو محال والعمل بدليل العقل لا يبطل عموم الكتاب بالكلية بل غايته إخراج بعض ما تناوله اللفظ من جهة اللغة عن كونه مراداً للمتكلم وهو غير ممتنع فكان العمل بدليل العقل متعيناً.
قولهم: إن الصبي والمجنون داخلان تحت الخطاب بأروش الجنايات وقيم المتلفات ليس كذلك فإنا إن نظرنا إلى تعلق الحق بمالهما فهو ثابت بخطاب الوضع والأخبار وهو غير متعلق بالصبي والمجنون وإن نظرنا إلى وجوب الأداء الثابت بخطاب التكليف فهو متعلق بفعل وليهما لا بفعلهما.
وأما صحة صلاة الصبي واختلاف الناس في صحة إسلامه فلا يدل ذلك على كونه داخلاً تحت خطاب التكليف بالصلاة والإسلام.
أما صحة الصلاة فمعناها انعقادها سبباً لثوابه وسقوط الخطاب عنه بها إذا صلى في أول الوقت وبلغ في آخره لا بمعنى أنه امتثل أمر الشارع حتى يكون داخلاً تحت خطاب التكليف من الشارع بل إن كان ولا بد فهو داخل تحت خطاب الولي لفهمه بخطابه دون خطاب الشرع وعلى هذا يكون الجواب عن صحة إسلامه عند من يقول بذلك وبتقدير امتناع تخصيص الصبي بدليل العقل مع تسليم جواز التخصيص به في الجملة كما تقدم بيانه فغير مضر ولا قادح فإنه ليس المقصود تحقيق ذلك في آحاد الصور.
وكما أن دليل العقل قد يكون مخصصاً للعموم فكذلك دليل الحس وذلك كما في قوله تعالى: " تدمر كل شيء " " الأحقاف 25 " مع خروج السماوات والأرض عن ذلك حساً وكذلك قوله تعالى: " ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم " " الذاريات 42 " وقد أتت على الأرض والجبال ولم تجعلها رميماً بدلالة الحس فكان الحس هو الدال على أن ما خرج عن عموم اللفظ لم يكن مراداً للمتكلم فكان مخصصاً.
المسألة الثانية اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافاً لبعض الطوائف ودليله المنقول والمعقول.
وأما المنقول فهو أن قوله: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " " الطلاق 4 " ورد مخصصاً لقوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً " " البقرة 234 " وقوله تعالى: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " " المائدة 5 " ورد مخصصاً لقوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " " البقرة 221 " والوقوع دليل الجواز.
وأما المعقول فهو أنه إذا اجتمع نصان من الكتاب أحدهما عام والآخر خاص وتعذر الجمع بين حكميهما فإما أن يعمل بالعام أو الخاص: فإن عمل بالعام لزم منه إبطال الدليل الخاص مطلقاً ولو عمل بالخاص لا يلزم منه إبطال العام مطلقاً لإمكان العمل به فيما خرج عنه كما سبق فكان العمل بالخاص أولى ولأن الخاص أقوى في دلالته وأغلب على الظن لبعده عن احتمال التخصيص بخلاف العام فكان أولى بالعمل.
وعند ذلك فإما أن يكون الدليل الخاص المعمول به ناسخاً لحكم العام في الصورة الخارجة عنه أو مخصصاً له والتخصيص أولى من النسخ لثلاثة أوجه:
الأول: أن النسخ يستدعي ثبوت أصل الحكم في الصورة الخاصة ورفعه بعد ثبوته والتخصيص ليس فيه سوى دلالته على عدم إرادة المتكلم للصور المفروضة بلفظة العام فكان ما يتوقف عليه النسخ أكثر مما يتوقف عليه التخصيص فكان التخصيص أولى.
الثاني: أن النسخ رفع بعد الإثبات والتخصيص منع من الإثبات والدفع أسهل من الرفع.
الثالث: أن وقوع التخصيص في الشرع أغلب من النسخ فكان الحمل على التخصيص أولى إدراجاً له تحت الأغلب وسواء جهل التاريخ أو علم وسواء كان الخاص متقدماً أو متأخراً.
فإن قيل: لو كان الكتاب مبيناً للكتاب لخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه مبيناً للكتاب وهو خلاف قوله تعالى: " لتبين للناس ما نزل إليهم " " النحل 44 " وهو ممتنع.
قلنا: إضافة البيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يمنع من كونه مبيناً للكتاب بالكتاب إذ الكل وارد على لسانه فذكره الآية المخصصة يكون بياناً منه ويجب حمل وصفه بكونه مبيناً على أن البيان وارد على لسانه كان الوارد على لسانه الكتاب أو السنة لما فيه من موافقة عموم قوله تعالى: " ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء " فإن مقتضاه أن يكون الكتاب مبيناً لكل ما هو من الكتاب لكونه شيئاً غير أنا خالفناه في البعض فيجب بالبعض الآخر تقليلاً لمخالفة الدليل العام.
فإن قيل: ما ذكرتموه وإن صح فيما إذا كان الخاص متأخراً ولا يصح فيما إذا جهل التاريخ وذلك لأنه يحتمل أن يكون الخاص مقدماً فيكون العام بعده ناسخاً له ويحتمل أن يكون العام متقدماً فيكون الخاص مخصصاً له ولم يترجح أحدهما على الآخر فوجب التعارض والتساقط والرجوع إلى دليل آخر كما ذهب إليه أبو حنيفة والقاضي أبو بكر والإمام أبو المعالي.
وإن سلمنا كون الخاص مخصصاً مع الجهل بالتاريخ فلا يصح فيما إذا كان العام متأخراً عن الخاص فإنه يتعين أن يكون ناسخاً لمدلول الخاص لا أن يكون الخاص مخصصاً للعام على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة وبيانه من أربعة أوجه: الأول: أنه إذا قال: اقتلوا المشركين فهو جار مجرى قوله اقتلوا زيداً المشرك وعمراً المشرك وخالداً وهلم جرا فإذا الخاص كقوله اقتلوا زيداً المشرك إذا ورد العام بعده بنفي القتل عن الجميع فهو ناص على زيد ولو قال اقتلوا زيداً لا تقتلوا زيداً كان نسخاً.
الثاني: أن الخاص المتقدم يمكن نسخه والعام الوارد بعده مما يمكن أن يكون ناسخاً فكان ناسخاً.
الثالث: هو أن الخاص المتقدم متردد بين كونه منسوخاً ومخصصاً لما بعده وذلك مما يمنع من كونه مخصصاً لأن البيان لا يكون ملتبساً.
الرابع: قول ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث والعام المتأخر أحدث فوجب الأخذ به.
قلنا: أما الجواب عن التعارض عند الجهل بالتاريخ فيما ذكرناه من الأدلة السابقة على الترجيح.
وأما الجواب عن حجج أصحاب أبي حنيفة: أما عن الأول فيمتنع كون العام في تناوله لما تحته من الأشخاص جار مجرى الألفاظ الخاصة إذ الألفاظ الخاصة بكل واحد واحد غير قابلة للتخصيص بخلاف اللفظ العام.
وعن الثاني: أنه لا يلزم من إمكان نسخه للخاص الوقوع ولو لزم من الإمكان الوقوع للزم أن يكون الخاص مخصصاً للعام لإمكان كونه مخصصاً له ويلزم من ذلك أن يكون الخاص منسوخاً ومخصصاً لناسخه وهو محال.
وعن الثالث: أنهم إن أرادوا بتردد الخاص بين كونه منسوخاً ومخصصاً أن احتمال التخصيص مساو لاحتمال النسخ فهو ممنوع لما تقدم وإن أرادوا بذلك تطرق الاحتمالين إليه في الجملة فذلك لا يمنع من كونه مخصصاً ولو منع ذلك من كونه مخصصاً لمنع تطرق احتمال كون العام مخصصاً بالخاص إليه من كونه ناسخاً.
وعن الرابع: أنه قول واحد من الصحابة فيجب حمله على ما إذا كان الأحدث هو الخاص جمعاً بين الأدلة.
المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة جائز عند الأكثرين ودليله المعقول والمنقول أما المعقول فما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب.
وأما المنقول فهو أن قوله صلى الله عليه وسلم: " لا زكاة فيما دون خمسة أوسق " ورد مخصصاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " فيما سقت السماء العشر " فإنه عام في النصاب وما دونه وقوله تعالى: " لتبين للناس ما نزل إليهم " " النحل 44 " مما لا يمنع من كونه مبيناً لما ورد على لسانه من السنة بسنة أخرى كما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب.
المسألة الرابعة يجوز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن عندنا وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين ومنهم من منع من ذلك ودليله العقل والنقل.
أما النقل فقوله تعالى: " وأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء " " النحل 89 " وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأشياء فكانت داخلة تحت العموم إلا انه قد خص في البعض فيلزم العمل به في الباقي وأما المعقول فما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب.
فإن قيل: الآية معارضة بقوله تعالى: " لتبين للناس ما نزل إليهم " " النحل 44 " ووجه الاحتجاج به أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً للكتاب المنزل وذلك إنما يكون بسنته فلو كان الكتاب مبيناً للسنة لكان المبين بالسنة مبيناً لها وهو ممتنع وأيضاً فإن المبين أصل والبيان تبع له ومقصود من أجله فلو كان القرآن مبينا للسنة لكانت السنة أصلاً والقرآن تبعاً وهو محال.
وجواب الآية أنه لا يلزم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه مبيناً لما أنزل امتناع كونه مبيناً للسنة بما يرد على لسانه من القرآن إذ السنة أيضاً منزلة على ما قال تعالى: " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " " النجم 3 " غير أن الوحي منه ما يتلى فيسمى كتاباً ومنه ما لا يتلى فيسمى سنة وبيان أحد المنزلين بالآخر غير ممتنع.
وما ذكروه من المعنى فغير صحيح فإن القرآن لا بد وأن يكون مبيناً لشيء ضرورة قوله تعالى: " تبياناً لكل شيء " " النحل 89 " وأي شيء قدر كون القرآن مبيناً له فليس القرآن تبعاً له ولا ذلك الشيء متبوعاً وأيضاً فإن الدليل القطعي قد يبين به مراد الدليل الظني وليس منحطاً عن رتبة الظني.
المسألة الخامسة يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة أما إذا كانت السنة متواترة فلم أعرف فيه خلافاً ويدل على جواز ذلك ما مر من الدليل العقلي.
وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة جوازه ومن الناس من منع ذلك مطلقاً ومنهم من فصل وهؤلاء اختلفوا فذهب عيسى بن أبان إلى أنه إن كان قد خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا وذهب الكرخي إلى أنه إن كان قد خص بدليل منفصل لا متصل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف والمختار مذهب الأئمة ودليله العقل والنقل.
أما النقل فهو أن الصحابة خصوا قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " " النساء 24 " بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها " وخصوا قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم " " النساء 11 " الآية بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يرث القاتل ولا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر " وبما رواه أبو بكر من قوله صلى الله عليه وسلم: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " وخصوا قوله تعالى: " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " " النساء 11 " بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للجدة السدس وخصوا قوله تعالى: " وأحل الله البيع " " البقرة 275 " بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين وخصوا قوله تعالى: " والسارق والسارقة " " المائدة 38 " وأخرجوا منه ما دون النصاب بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً " وخصوا قوله تعالى: " اقتلوا المشركين " " التوبة 5 " بإخراج المجوس منه بما روي عنه عليه السلام أنه قال " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " إلى غير ذلك من الصور المتعددة ولم يوجد لما فعلوه نكير فكان ذلك إجماعاً والوقوع دليل الجواز وزيادة وأما المعقول فما ذكرناه فيما تقدم في تخصيص الكتاب بالكتاب.
فإن قيل: ما ذكرتموه من التخصيص في الصور المذكورة لا نسلم أن تخصيصها كان بخبر الواحد ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم " إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فردوه " والخبر فيما نحن فيه مخالف للكتاب فكان مردوداً.
قولهم إن الصحابة أجمعوا على ذلك إن لم يصح فليس بحجة وإن صح فالتخصيص بإجماعهم عليه لا بخبر الواحد كيف وأنه لا إجماع على ذلك ويدل عليه ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كذب فاطمة بنت قيس فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان ذلك مخصصاً لعموم قوله تعالى: " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " " الطلاق 6 " وقال: كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة.
وإن سلمنا الإجماع على أن التخصيص كان بخبر الواحد لكن ليس في ذلك ما يدل على أن قول الواحد بمجرده مخصص بل ربما قامت الحجة عندهم على صدقه وصحة قوله بقرائن وأدلة اقترنت بقوله فلا يكون مجرد إخباره حجة.
وأما ما ذكرتموه من المعقول فنقول: خبر الواحد وإن كان نصاً في مدلوله نظراً إلى متنه غير أن سنده مظنون محتمل للكذب بخلاف القرآن المتواتر فإنه قطعي السند وقطعي في دلالته على كل واحد من الآحاد الداخلة فيه لما بيناه في المسألة المتقدمة ولا يكون خبر الواحد واقعاً في معارضته كما في النسخ.
وإن سلمنا أن العموم ظني الدلالة بالنسبة إلى آحاده لكن متى إذا خص بدليل مقطوع على ما قاله عيسى بن إبان أو بدليل منفصل على ما قاله الكرخي أو قبل التخصيص الأول مسلم لكونه صار مجازاً ظنياً والثاني ممنوع لبقائه على حقيقته وعند ذلك فيمتنع التخصيص بخبر الواحد مطلقاً لترجيح العام عليه قبل التخصيص بكونه قاطعاً في متنه وسنده.
وإن سلمنا أن دلالة العام بالنظر إلى متنه ظنية مطلقاً غير أنه قطعي السند والخبر وإن كان قاطعاً في متنه فظني في سنده فقد تقابلا وتعارضا ووجب التوقف على دليل خارج لعدم أولوية أحدهما كما قال القاضي أبو بكر.
والجواب: قد بينا أن الصحابة أجمعوا على تخصيص العمومات بأخبار الآحاد حيث إنهم أضافوا التخصيص إليها من غير نكير فكان إجماعاً.
وما ذكروه من الخبر فإنما يمنع من تخصيص عموم القرآن بالخبر أن لو كان الخبر المخصص مخالفاً للقرآن وهو غير مسلم بل هو مبين للمراد منه فكان مقرراً لا مخالفاً ويجب اعتقاد ذلك حتى لا يفضي إلى تخصيص ما ذكروه من الخبر بالخبر المتواتر من السنة فإنه مخصص للقرآن من غير خلاف.
قولهم إن صح إجماع الصحابة فالتخصيص بإجماعهم لا بالخبر ليس كذلك فإن إجماعهم لم يكن على تخصيص تلك العمومات مطلقاً بل على تخصيصها بأخبار الآحاد ومهما كان التخصيص بأخبار الآحاد مجمعاً عليه فهو المطلوب.
وأما ما ذكروه من تكذيب عمر لفاطمة بنت قيس فلم يكن ذلك لأن خبر الواحد في تخصيص العموم مردود عنده بل لتردده في صدقها ولهذا قال: كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ولو كان خبر الواحد في ذلك مردوداً مطلقاً لما احتاج إلى هذا التعليل.
قولهم: لم يكن إجماعهم على ذلك لمجرد خبر الواحد قلنا: ونحن لا نقول بأن مجرد خبر الواحد يكون مقبولاً بل إنما يقبل إذا كان مغلباً على الظن صدقه ومع ذلك فالأصل عدم اعتبار ما سواه في القول.
قولهم إن سند الخبر ظني مسلم ولكن لا نسلم أن دلالة العموم على الآحاد الداخلة فيه قطعية لاحتماله للتخصيص بالنسبة إلى أي واحد منها قدر وسواء كان قد خص أو لم يكن على ما سبق بيانه.
وأما النسخ فلا نسلم امتناعه بخبر الواحد وبتقدير التسليم فلأن النسخ رفع للحكم بعد إثباته بخلاف التخصيص لأنه بيان لا رفع فلا يلزم مع ذلك من امتناع النسخ به امتناع التخصيص.
وما ذكروه من السؤال الأخير في جهة التعارض فجوابه أن احتمال الضعف في خبر الواحد من جهة كذبه وفي العام من جهة جواز تخصيصه ولا يخفى أن احتمال الكذب في حق من ظهرت عدالته أبعد من احتمال التخصيص العام ولهذا كانت أكثر العمومات مخصصة وليس أكثر أخبار العدول كاذبة فكان العمل بالخبر أولى ولأنه لو عمل بعموم العام لزم إبطال العمل بالخبر مطلقاً ولو عمل بالخبر لم يلزم منه إبطال العمل بالعام مطلقاً لإمكان العمل به فيما سوى صورة التخصيص والجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من تعطيل أحدهما ولأن العمل بالعام إبطال للخاص والعمل بالخاص بيان للعام لا إبطال له ولا يخفى أن البيان أولى من الإبطال.
المسألة السادسة
لا أعرف خلافاً في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع ودليله المنقول والمعقول: أما المنقول فهو أن إجماع الأمة خصص آية القذف بتنصيف الجلد في حق العبد كالأمة.
وأما المعقول فهو أن الإجماع دليل قاطع والعام غير قاطع في آحاد مسمياته كما سبق تعريفه فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور علمنا أنهم ما قضوا به إلا وقد اطلعوا على دليل مخصص له نفيا للخطأ عنهم وعلى هذا فمعنى إطلاقنا أن الإجماع مخصص للنص أنه معرف للدليل المخصص لا أنه في نفسه هو المخصص.
وبالنظر إلى هذا المعنى أيضاً نقول: إنا إذا رأينا عمل الصحابة وأهل الإجماع بما يخالف النص الخاص لا يكون ذلك إلا لاطلاعهم على ناسخ للنص فيكون الإجماع معرفاً للناسخ لا أنه ناسخ وإنما قلنا إن الإجماع نفسه لا يكون ناسخاً لأن النسخ لا يكون بغير خطاب الشارع والإجماع ليس خطاباً للشرع وإن كان دليلاً على الخطاب الناسخ.
المسألة السابعة لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة حتى إنه لو قال السيد لعبده كل من دخل داري فاضربه ثم قال: إن دخل زيد داري فلا تقل له: أف فإن ذلك يدل على تحريم ضرب زيد وإخراجه عن العموم نظراً إلى مفهوم الموافقة وما سيق له الكلام من كف الأذى عن زيد وسواء قيل إن تحريم الضرب مستفاد من دلالة اللفظ أو من القياس الجلي على اختلاف المذاهب في ذلك كما يأتي وكذا لو ورد نص عام يدل على وجوب الزكاة في الأنعام كلها ثم ورد قوله صلى الله عليه وسلم " في الغنم السائمة زكاة " فإنه يكون مخصصاً للعموم بإخراج معلوفة الغنم عن وجوب الزكاة بمفهومه وإنما كان كذلك لأن كل واحد من المفهومين دليل شرعي وهو خاص في مورده فوجب أن يكون مخصصاً للعموم لترجح دلالة الخاص على دلالة العام كما سبق تقريره.
فإن قيل: المفهوم وإن كان خاصاً وأقوى في الدلالة من العموم إلا أن العام منطوق به والمنطوق أقوى في دلالته من المفهوم لافتقار المفهوم في دلالته إلى المنطوق وعدم افتقار المنطوق في دلالته إلى المفهوم.
قلنا: إلا أن العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقاً ولا كذلك بالعكس ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطال أصل الآخر.
المسألة الثامنة في تخصيص العموم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اختلف القائلون بكون فعل الرسول حجة على غيره هل يجوز تخصيصه للعموم أم لا؟ فأثبته الأكثرون كالشافعية والحنفية والحنابلة ونفاه الأقلون كالكرخي.
وتحقيق الحق من ذلك يتوقف على التفصيل وهو أن نقول: العام الوارد إما أن يكون عاماً للأمة والرسول كما لو قال صلى الله عليه وسلم " الوصال أو استقبال القبلة في قضاء الحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم " وإما أن يكون عاماً للأمة دون الرسول كما لو قال صلى الله عليه وسلم: " نهيتكم عن الوصال أو استقبال القبلة في قضاء الحاجة أو كشف الفخذ " فإن كان الأول فإذا رأيناه قد واصل أو استقبل القبلة في قضاء الحاجة أو كشف فخذه فلا خلاف في أن فعله يدل على إباحة ذلك الفعل في حقه ويكون مخرجاً له عن العموم ومخصصاً.
وأما بالنسبة إلى غيره فإما أن نقول بأن اتباعه في فعله والتأسي به واجب على كل من سواه أو لا نقول ذلك.
فإن قيل بالأول فيلزم منه رفع حكم العموم مطلقاً في حقه بفعله وفي حق غيره بوجوب التأسي به فلا يكون ذلك تخصيصاً بل نسخا لحكم العموم مطلقاً بالنسبة إليه وإلى غيره وإن قيل بالثاني كان ذلك تخصيصاً له عن العموم دون أمته.
وأما إن كان عاماً للأمة دون الرسول ففعله لا يكون مخصصاً لنفسه عن العموم لعدم دخوله فيه وأما بالنسبة إلى الأمة فإن قيل أيضاً بوجوب اتباع الأمة له في فعله كان ذلك أيضاً نسخاً عنهم لا تخصيصا كما سبق وإن لم يكن ذلك واجباً عليهم فلا يكون فعله مخصصاً للعموم أصلا لا بالنسبة إليه لعدم دخوله في العموم ولا بالنسبة إلى الأمة وعلى هذا التفصيل فلا أرى للخلاف على هذا التخصيص بفعل النبي وجهاً: أما إذا كان هو المخصص عن العموم وحده فلعدم الخلاف فيه وأما في باقي الأقسام فلعدم تحقق التخصيص بل إن وقع الخلاف في باقي الأقسام هل فعله يكون ناسخاً لحكم العموم فيها فخارج عن الخوض في باب التخصيص والأظهر في ذلك إنما هو الوقف من جهة أن دليل وجوب التأسي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بدليل عام للأمة وهو مساو للعموم الآخر في عمومه وليس العمل بأحدهما وإبطال الآخر أولى من العكس.
فإن قيل: بل العمل بالفعل أولى لأنه خاص والخاص مقدم على العام قلنا: الفعل لم يكن دليلاً على لزوم الحكم في حق باقي الأمة بنفسه بل لأدلة عامة موجبة على الأمة لزوم الاتباع.
فإن قيل: إلا أن الفعل الخاص مع العمومات الموجبة للتأسي أخص من اللفظ العام مطلقاً ولأنه متأخر عن العام والمتأخر أولى بالعمل.
قلنا: أما الفعل فلا نسلم أن له دلالة على وجوب تأسي الأمة بالنبي بوجه من الوجوه بل الموجب شيء آخر وهو مساو للعام الآخر في عمومه وسواء كان الفعل خاصاً أو عاماً وذلك الموجب للتأسي غير متأخر عن العام بل محتمل للتقدم والتأخر من غير ترجيح حتى إنه لو علم التاريخ وجب العمل بالمتأخر منهما كيف وإن القول بوجوب التأسي متوقف على وجود الفعل وعلى الدليل الدال على التأسي ولا كذلك العام الآخر وما يتوقف العمل به على أمرين يكون أبعد مما لا يتوقف العمل به إلا على شيء واحد.
المسألة التاسعة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفاً للعموم وعدم إنكاره عليه مع علمه به وعدم الغفلة والذهول عنه مخصص لذلك العام عند الأكثرين خلافاً لطائفة شاذة.
ودليل ذلك أن تقريره له عليه دليل على جواز ذلك الفعل له وإلا كان فعله منكراً ولو كان كذلك لاستحال من النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عنه وعدم النكير عليه وإذا كان التقرير دليل الجواز وإن أمكن نسخ ذلك الحكم مطلقاً أو نسخه عن ذلك الواحد بعينه لكنه بعيد واحتمال تخصيصه من العموم أولى وأقرب لما قررناه فيما تقدم وعند ذلك فإن أمكن تعقل معنى أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم فكل من كان مشاركاً له في ذلك المعنى فهو مشارك له في تخصيصه عن ذلك العام بالقياس عليه عند من يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص وأما إن لم يظهر المعنى الجامع فلا.
فإن قيل: التقرير لا صيغة له فلا يقع في مقابلة ما له صيغة فلا يكون مخصصاً للعموم وبتقدير أن يكون مخصصاً فلا بد وأن يكون غير ذلك الواحد مشاركاً له في حكمه وإلا فلو لم يكن غير ذلك الواحد مشاركاً له في حكمه لصرح النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيصه بذلك الحكم دون غيره دفعاً لمحذور التلبيس على الأمة باعتقادهم المشاركة لذلك الواحد في حكمه لقوله صلى الله عليه وسلم " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " .
قلنا: وإن كان التقرير لا صيغة له غير أنه حجة قاطعة في جواز الفعل نفياً للخطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف العام فإنه ظني محتمل للتخصيص فكان موجباً لتخصيصه وما ذكروه من وجوب المشاركة فبعيد وذلك لأن حكم ذلك الواحد لا يخلو: إما أن يكون له أو عليه فإن كان له فقوله: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لا يكون مرتبطاً به وإن كان عليه فقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة إنما يكون حجة موهمة لمشاركة الجماعة لذلك الواحد إن لو كان قوله حكمي عاماً في كل حكم وهو غير مسلم وإذا لم يكن ذلك حجة عامة فلا تدليس ولا تلبيس وبتقدير مشاركة الأمة لذلك الواحد في ذلك الحكم يكون نسخاً ولا يكون تخصيصاً كما ظن بعضهم.
المسألة العاشرة
مذهب الشافعي في القول الجديد ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم وسواء كان هو الراوي أو لم يكن لا يكون مخصصاً للعموم خلافاً لأصحاب أبي حنيفة والحنابلة وعيسى بن أبان وجماعة من الفقهاء.
ودليله أن ظاهر العموم حجة شرعية يجب العمل بها باتفاق القائلين بالعموم ومذهب الصحابي ليس بحجة على ما سنبينه فلا يجوز ترك العموم به.
فإن قيل: إذا خالف مذهب الصحابي العموم فلا يخلو إما أن يكون ذلك لدليل أو لا لدليل لا جائز أن يكون لا لدليل وإلا وجب تفسيقه والحكم بخروجه عن العدالة وهو خلاف الإجماع وإن كان ذلك لدليل وجب تخصيص العموم به جمعاً بين الدليلين إذ هو أولى من تعطيل أحدهما كما علم غير مرة.
قلنا: مخالفة الصحابي للعموم إنما كانت لدليل عن له في نطره وسواء كان في نفس الأمر مخطئاً فيه أو مصيباً فلذلك لم نقض بتفسيقه لكونه مأخوذاً باتباع اجتهاده وما أوجبه ظنه ومع ذلك فلا يكون ما عن له في نظره حجة متبعة بالنسبة إلى غيره بدليل جواز مخالفة صحابي آخر له من غير تفسيق ولا تبديع وإذا لم يكن ما صار إليه حجة واجبة الاتباع بالنسبة إلى الغير فلا يكون مخصصاً لظاهر العموم المتفق على صحة الاحتجاج به مطلقاً.
المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام كقوله: حرمت عليكم الطعام فقد اتفق الجمهور من العلماء على إجراء اللفظ على عمومه في تحريم كل طعام على وجه يدخل فيه المعتاد وغيره وأن العادة لا تكون منزلة للعموم على تحريم المعتاد دون غيره خلافاً لأبي حنيفة وذلك لأن الحجة إنما هي في اللفظ الوارد وهو مستغرق لكل مطعوم بلفظه ولا ارتباط له بالعوائد وهو حاكم على العوائد فلا تكون العوائد حاكمة عليه.
فإن قيل: إذا منعتم من تجويز تخصيص العموم بالعادة وتنزيل لفظ الطعام على ما هو المعتاد المتعارف عند المخاطبين فما الفرق بينه وبين تخصيص اللفظ ببعض مسمياته في اللغة بالعادة وذلك كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع وإن كان لفظ الدابة عاماً في كل ما يدب وكتخصيص اسم الثمن في البيع بالنقد الغالب في البلد حتى إنه لا يفهم من إطلاق لفظ الدابة والثمن غير ذوات الأربع والنقد الغالب في البلد.
قلنا: الفرق بين الأمرين أن العادة في محل النزاع إنما هي مطردة في اعتياد أكل ذلك الطعام المخصوص لا في تخصيص اسم الطعام بذلك الطعام الخاص فلا يكون ذلك قاضياً على ما اقتضاه عموم لفظ الطعام مع بقائه على الوضع الأصلي وهذا بخلاف لفظ الدابة فإنه صار بعرف الاستعمال ظاهراً في ذوات الأربع وضعاً حتى إنه لا يفهم من إطلاق لفظ الدابة غير ذوات الأربع فكان قاضياً على الاستعمال الأصلي حتى إنه لو كانت العادة في الطعام المعتاد أكله قد خصصت بعرف الاستعمال اسم الطعام بذلك الطعام لكان لفظ الطعام منزلاً عليه دون غيره ضرورة تنزيل مخاطبة الشارع للعرب على ما هو المفهوم لهم من لغتهم وفيه دقة مع وضوحه.
المسألة الثانية عشرة اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصاً للعام بجنس مدلول الخاص ومخرجاً عنه ما سواه خلافاً لأبي ثور من أصحاب الشافعي وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم " أيما إهاب دبغ فقد طهر " فإنه عام في كل إهاب وقوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة " دباغها طهورها " وإنما لم يكن مخصصاً له لأنه لا تنافي بين العمل بالخاص وإجراء العام على عمومه ومع إمكان إجراء كل واحد على ظاهره لا حاجة إلى العمل بأحدهما ومخالفة الآخر.
فإن قيل: فقد اخترتم أن المفهوم يكون مخصصاً للعموم عند القائل به وتخصيص جلد الشاة بالذكر يدل بمفهومه على نفي الحكم عما سوى الشاة من جلود باقي الحيوانات فكان مخصصاً للعموم الوارد بتطهيرها.
قلنا: أما من نفي كون المفهوم حجة وأبطل دلالته كما يأتي تحقيقه فلا أثر لإلزامه به هاهنا ومن قال بالمفهوم المخصص للعموم إنما قال به في مفهوم الموافقة ومفهوم الصفة المشتقة كما سبق في المسألة المتقدمة لا في مفهوم اللقب وتخصيص جلد الشاة بالذكر لا يدل على نفي الطهارة بالدباغ عن باقي جلود الحيوانات كالإبل والبقرة وغيرها إلا بطريق مفهوم اللقب وليس بحجة على ما يأتي تحقيقه ولهذا فإنه لو قال: عيسى رسول الله فإنه لا يدل على أن محمداً ليس برسول الله وكذلك إذا قال: الحادث موجود لا يدل على أن القديم ليس بموجود وإلا كان ذلك كفراً.
المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم لا إلى كله هل يكون خصوص المتأخر مخصصاً للعام المتقدم بما الضمير عائد إليه أو لا؟ اختلفوا فيه: فذهب بعض أصحابنا وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وغيره إلى امتناع التخصيص بذلك ومنهم من جوزه ومنهم من توقف كإمام الحرمين وأبي الحسين البصري وذلك كما في قوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ " " البقرة 228 " فإنه عام في كل الحرائر المطلقات بوائن كن أو رجعيات ثم قال: " وبعولتهن أحق بردهن " " البقرة 228 " فإن الضمير فيه إنما يرجع إلى الرجعيات دون البوائن وعلى هذا النحو.
والمختار بقاء اللفظ الأول على عمومه وامتناع تخصيصه بما تعقبه وذلك لأن مقتضى اللفظ إجراؤه على ظاهره من العموم ومقتضى اللفظ الثاني عود الضمير إلى جميع ما دل عليه اللفظ المتقدم إذ لا أولوية لاختصاص بعض المذكور السابق به دون البعض فإذا قام الدليل على تخصيص الضمير ببعض المذكور السابق وخولف ظاهره لم يلزم منه مخالفة الظاهر الأخير بل يجب إجراؤه على ظاهره إلى أن يقوم الدليل على تخصيصه.
فإن قيل: إنما يلزم مخالفة ظاهر ما اقتضاه الضمير من العود إلى كل المذكور السابق إذا أجرينا اللفظ السابق على عمومه وليس القول بإجرائه على عمومه ومخالفة ظاهر الضمير أولى من إجراء ظاهر الضمير على مقتضاه وتخصيص المذكور السابق وإذا لم يترجح أحدهما وجب الوقف.
قلنا: بل إجراء اللفظ المتقدم على عمومه وتخصيص المتأخر أولى من العكس لأن دلالة الأول ظاهرة ودلالة الثاني غير ظاهرة ولا يخفى أن دلالة المظهر أقوى من دلالة المضمر فكان راجحاً.
المسألة الرابعة عشرة القائلون بكون العموم والقياس حجة اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس: فذهب الأئمة الأربعة والأشعري وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي الحسين البصري إلى جوازه مطلقاً وذهب الجبائي وجماعة من المعتزلة إلى تقديم العام على القياس وذهب ابن سريج وغيره من أصحاب الشافعي إلى جواز التخصيص بجلي القياس دون خفيه وذهب عيسى بن أبان والكرخي إلى جواز التخصيص بالقياس للعام المخصص دون غيره غير أن الكرخي اشترط أن يكون العام مخصصاً بدليل منفصل وأطلق عيسى بن أبان ومنهم من جوز التخصيص بالقياس إذا كان أصل القياس من الصور التي خصت عن العموم دون غيره وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى الوقف.
والمختار أنه إذا كانت العلة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير أي بنص أو إجماع جاز تخصيص العموم به وإلا فلا.
أما إذا كانت العلة مؤثرة فلأنها نازلة منزلة النص الخاص فكانت مخصصة للعموم كتخصيصه بالنص كما سبق تعريفه.
وأما إذا كانت العلة مستنبطة غير مؤثرة فإنما قلنا بامتناع التخصيص بها للإجمال والتفصيل: أما الإجمال فهو أن العام في محل التخصيص: إما أن يكون راجحاً على القياس المخالف له أو مرجوحاً أو مساوياً فإن كان راجحاً امتنع تخصيصه بالمرجوح وإن كان مساوياً فليس العمل بأحدهما أولى من الآخر وإنما يمكن التخصيص بتقدير أن يكون القياس في محل المعارضة راجحاً ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه وأما التفصيل فهو أن العموم ظاهر في كل صورة من آحاد الصور الداخلة تحته وجهة ضعفه غير خارجة عن احتمال تخصيصه أو كذب الراوي إن كان العام من أخبار الآحاد.
وأما احتمالات ضعف القياس فكثيرة جداً وذلك لأنه وإن كان متناولاً لمحل المعارضة بخصوصه إلا أنه يحتمل أن يكون دليل حكم الأصل من أخبار الآحاد التي يتطرق إليها الكذب
وبتقدير أن يكون طريق إثباته قطعياً فيحتمل أن يكون المستنبط القياس ليس أهلا له وبتقدير أن يكون أهلاً فيحتمل أن لا يكون الحكم في نفس الأمر معللا بعلة ظاهرة وبتقدير أن يكون معللاً بعلة ظاهرة فلعلها غير ما ظنه القائس علة ولم يظهر عليها أو أنه أخطأ في طريق إثبات العلة فأثبتها بما لا يصلح للإثبات وبتقدير أن تكون العلة ما ظنه فلعله ظن وجودها في الفرع ولا وجود لها فيه وبتقدير أن تكون موجودة فيه يحتمل أن يكون قد وجد في الفرع مانع السبب أو مانع الحكم أو فات شرط السبب فيه أو شرط الحكم فكان العموم لذلك راجحاً كيف وأن العموم من جنس النصوص والنص غير مفتقر في العمل به في جنسه إلى القياس والقياس متوقف في العمل به على النص لأنه إن ثبت كونه حجة بالنص فظاهر وإن كان بالإجماع فالإجماع متوقف على النص فكان القياس متوقفاً على النص فكان جنس النص لذلك راجحاً ولذلك وقع القياس مؤخراً في حديث معاذ في العمل به عن العمل بالكتاب والسنة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قاضياً " بم تحكم؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي فقال صلى الله عليه وسلم: " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله " ومقتضى ذلك أن لا تتقدم السنة على الكتاب غير أنا خالفناه في تقديم خاص السنة على عام الكتاب فوجب العمل به فيما عداه.
وهذه الاحتمالات كلها إن لم توجب الترجيح فلا أقل من المساواة وعلى كلا التقديرين فيمتنع تخصيص العام بالقياس.
فإن قيل: القول بالوقف خلاف الإجماع قبل وجود الواقفية إذ الأمة مجمعة على تقديم أحدهما وإن اختلفوا في التعيين ولأن القول بالوقف مما يفضي إلى تعطيل الدليلين عن العمل بهما والمحذور فيه فوق المحذور في العمل بأحدهما فالعمل بالقياس أولى لأنا لو عملنا بالعموم لزم منه إبطال العمل بالقياس مطلقاً ولو عملنا بالقياس لم يلزم منه إبطال العموم مطلقاً لإمكان العمل به فيما عدا صورة التخصيص ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر.
قلنا: نحن لا نقول بالوقف لما بيناه من ترجيح العمل بالعموم على العمل بالقياس وبتقدير القول بالوقف لا نسلم إجماع الأمة على إبطاله بل غايته أن كل واحد رأى ترجيحاً فيما ذهب إليه وذلك لا يدل على إجماعهم على إبطال الوقف إلا أن يوجد منهم التصريح بذلك وهو غير مسلم ولهذا فإن كل واحد من المجتهدين لا يقطع بإبطال مذهب مخالفه مع مصيره إلى نفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه فلأن لا يكون قاطعاً بإبطاله عند توقفه في نفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أولى.
قولهم إن العمل بالقياس غير مبطل للعمل بالعموم قلنا: في محل المعارضة أو في غيرها؟ الأول ممنوع والثاني مسلم والنزاع إنما وقع في الترجيح في محل المعارضة دون غيره.
وبالجملة فلا يمتنع على المجتهد في هذه المسألة الحكم بالوقف أو الترجيح على حسب ما يظهر في نظره في آحاد الوقائع من القرائن والترجيحات الموجبة للتفاوت أو التساوي من غير تخطئة إذ الأدلة فيها نفياً وإثباتاً ظنية غير قطعية فكانت ملحقة بالمسائل الاجتهادية دون القطعية خلافاً للقاضي أبي بكر ويجب أن نختم الكلام في أدلة التخصيص بالفرق بين التخصيص والاستثناء.
أما على رأي من يزعم أن الاستثناء والمستثنى منه كالكلمة الواحدة كما سبق فلا خفاء بأن الاستثناء لا يكون تخصيصاً بل هو مباين له وأما من يرى أن الاستثناء تخصيص فهو نوع من التخصيص عنده فكل استثناء تخصيص وليس كل تخصيص استثناء وذلك لأن الاستثناء لا بد وأن يكون متصلاً بالمستثنى منه على ما تقدم تقريره وأنه لا يثبت بقرائن الأحوال بخلاف غيره من أنواع التخصيص وعلى هذا يكون الحكم في التخصيص بذكر الشرط والغاية أيضاً.
/بسم الله الرحمن الرحيم الصنف السادس في المطلق والمقيد أما المطلق فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات.
فقولنا نكرة احتراز عن أسماء المعارف وما مدلوله واحد معين أو عام مستغرق.
وقولنا في سياق الإثبات احتراز عن النكرة في سياق النفي فإنها تعم جميع ما هو من جنسها وتخرج بذلك عن التنكير لدلالة اللفظ على الاستغراق وذلك كقولك في معرض الأمر اعتق رقبة أو مصدر الأمر كقوله: " فتحرير رقبة " المجادلة 3 أو الإخبار عن المستقبل كقوله سأعتق رقبة ولا يتصور الإطلاق في معرض الخبر المتعلق بالماضي كقوله رأيت رجلا ضرورة تعينه من إسناد الرؤية إليه.
وإن شئت قلت هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه فقولنا لفظ كالجنس للمطلق وغيره وقولنا دال احتراز عن الألفاظ المهملة وقولنا على مدلول ليعم الوجود والعدم وقولنا شائع في جنسه احتراز عن أسماء الأعلام وما مدلوله معين أو مستغرق.
وأما المقيد فإنه يطلق باعتبارين: الأول ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد وعمرو وهذا الرجل ونحوه الثاني ما كان من الألفاظ دالاً على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك دينار مصري ودرهم مكي وهذا النوع من المقيد وإن كان مطلقا في جنسه من حيث هو دينار مصري ودرهم مكي غير أنه مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار والدرهم فهو مطلق من وجه ومقيد من وجه.
وإذا عرف معنى المطلق والمقيد فكل ما ذكرناه في مخصصات العموم من المتفق عليه والمختلف فيه والمزيف والمختار فهو بعينه جار في تقييد المطلق فعليك باعتباره ونقله إلى هاهنا.
ونزيد مسألةً أخرى وهي أنه إذا ورد مطلق ومقيد فلا يخلو إما أن يختلف حكمهما أو لا يختلف: فإن اختلف حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر وسواء كانا مأمورين أو منهيين أو أحدهما مأموراً والآخر منهياً وسواء اتحد سببهما أو اختلف لعدم المنافاة في الجمع بينهما إلا في صورة واحدة.
وهي ما إذا قال مثلاً في كفارة الظهار أعتقوا رقبة ثم قال لا تعتقوا رقبة كافرة فإنه لا خلاف في مثل هذه الصورة أن المقيد يوجب تقييد الرقبة المطلقة بالرقبة المسلمة وعليك باعتبار أمثلة هذه الأقسام فإنها سهلة.
وأما إن لم يختلف حكمهما فلا يخلو إما أن يتحد سببهما أو لا يتحد: فإن اتحد سببهما فإما أن يكون اللفظ دالاً على إثباتهما أو نفيهما فإن كان الأول كما لو قال في الظهار اعتقوا رقبة ثم قال اعتقوا رقبة مسلمة فلا نعرف خلافاً في حمل المطلق على المقيد هاهنا وإنما كان كذلك لأن من عمل بالمقيد فقد وفى بالعمل بدلالة المطلق ومن عمل بالمطلق لم يف بالعمل بدلالة المقيد فكان الجمع هو الواجب والأولى.
فإن قيل بطريقه الشبهة إذا كان حكم المطلق إمكان الخروج عن عهدته بما شاء المكلف من ذلك الجنس فالعمل بالمقيد مما ينافي مقتضى المطلق وليس مخالفة المطلق وإجراء المقيد على ظاهره أولى من تأويل المقيد بحمله على الندب وإجراء المطلق على إطلاقه.
قلنا: بل التقييد أولى من التأويل لثلاثة أوجه: الأول: أنه يلزم منه الخروج عن العهدة بيقين ولا كذلك في التأويل.
الثاني: أن المطلق إذا حمل على المقيد فالعمل به فيه لا يخرج عن كونه موفياً للعمل باللفظ المطلق في حقيقته ولهذا لو أداه قبل ورود التقييد كان قد عمل باللفظ في حقيقته ولا كذلك في تأويل المقيد وصرفه عن جهة حقيقته إلى مجازه.
الثالث: أن الخروج عن العهدة بفعل أي واحد كان من الآحاد الداخلة تحت اللفظ المطلق لم يكن اللفظ دالا عليه بوضعه لغة بخلاف ما دل عليه المقيد من صفة التقييد.
ولا يخفى أن المحذور في صرف اللفظ عما دل عليه اللفظ لغة أعظم من صرفه عما لم يدل عليه بلفظه لغةً.
وأما إن كان دالاً على نفيهما أو نهى عنهما كما لو قال مثلاً في كفارة الظهار لا تعتق مكاتباً كافراً فهذا أيضاً مما لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما في النفي إذ لا تعذر فيه.
وأما إن كان سببهما مختلفاً كقوله تعالى في كفارة الظهار: " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " المجادلة 3 وقوله تعالى في القتل الخطأ: " ومن يقتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " فهذا مما اختلف فيه: فنقل عن الشافعي رضي الله عنه تنزيل المطلق على المقيد في هذه الصورة لكن اختلف الأصحاب في تأويله: فمنهم من حمله على التقييد مطلقاً من غير حاجة إلى دليل آخر ومنهم من حمله على ما إذا وجد بينهما علة جامعة مقتضية للإلحاق وهو الأظهر من مذهبه وأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم منعوا من ذلك مطلقاً.
ولنذكر حجة كل فريق ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار.
أما حجة من قال بالتقييد من غير دليل فهي أن كلام الله تعالى متحد في ذاته لا تعدد فيه فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتل كان ذلك تنصيصاً على اشتراطه في كفارة الظهار ولهذا حمل قوله تعالى: " والذاكرات " الأحزاب 35 على قوله في أول الآية: " والذاكرين الله كثيراً " الأحزاب 35 من غير دليل خارج.
وهذا مما لا اتجاه له فإن كلام الله تعالى إما أن يراد به المعنى القائم بالنفس أو العبارات الدالة عليه.
والأول وإن كان واحداً لا تعدد فيه غير أن تعلقه بالمتعلقات مختلف باختلاف المتعلق ولا يلزم من تعلقه بأحد المختلفين بالإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص أو غير ذلك أن يكون متعلقاً بالآخر وإلا كان أمره ونهيه ببعض المختلفات أمراً ونهياً بباقي المختلفات وهو محال متناقض بل وكان يلزم من تعلقه بالصوم المقيد في الحج بالتفريق حيث قال تعالى: " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " البقرة 196 وبالتتابع في الظهار حيث قال: " فصيام شهرين متتابعين " النساء 92 أن يتقيد الصوم المطلق في اليمين إما بالتتابع أو التفريق وهو محال أو بأحدهما دون الآخر ولا أولوية.
كيف وإنه يلزم من تقييده بأحدهما دون الآخر إبطال ما ذكروه من أن التنصيص على أحد المختلفين يكون تنصيصاً على الآخر.
وإن أريد به العبارة الدالة فهي متعددة غير متحدة ولا يلزم من دلالة بعضها على بعض الأشياء المختلفة دلالته على غيره وإلا لزم من ذلك المحال الذي قدمنا لزومه في الكلام النفساني.
وأما ما ذكروه من حمل الذاكرات على الذاكرين الله كثيراً فلا نسلم أن ذلك من غير دليل ودليله أن قوله تعالى: " والذاكرات " معطوف على قوله: " والذاكرين الله كثيراً " الأحزاب 35 ولا استقلال له بنفسه فوجب رده إلى ما هو معطوف عليه ومشارك له في حكمه.
وأما حجة أصحاب أبي حنيفة فإنهم قالوا: إذا امتنع التقييد من غير دليل لما سبق فلا بد من دليل ولا نص من كتاب أو سنة يدل على ذلك والقياس يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الخروج عن العهدة بأي شيء كان مما هو داخل تحت اللفظ المطلق كما سبق تقريره فيكون نسخاً ونسخ النص لا يكون بالقياس.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه يلزم من القياس نسخ النص المطلق بل تقييده ببعض مسمياته وذلك لا يدل على تخصيص العام بالقياس عندكم فكذلك التقييد.
كيف وإن لفظ الرقبة مطلق بالنسبة إلى السليمة والمعيبة وقد كان مقتضى ذلك أيضاً الخروج عن العهدة بالمعيبة وقد شرطتم صفة السلامة ولم يدل عليه نص من كتاب أو سنة وإن كان بالقياس فإما أن يكون نسخاً أو لا يكون نسخاً فإن كان الأول فقد بطل قولكم إن النسخ لا يكون بالقياس وإن لم يكن نسخاً فقد بطل قولكم إن رفع حكم المطلق بالقياس يكون نسخاً.
وأما حجة من قال بالتقييد بناء على القياس فالوجه في ضعفه ما سبق في تخصيص العام بالقياس فعليك بنقله إلى هاهنا.
والمختار أنه إن كان الوصف الجامع بين المطلق والمقيد مؤثرا أي ثابتا بنص أو إجماع وجب القضاء بالتقييد بناء عليه وإن كان مستنبطا من الحكم المقيد فلا كما ذكرناه في تخصيص العموم.
الصنف السابع في المجمل ويشتمل على مقدمة ومسائل : أما المقدمة ففي معنى المجمل وهو في اللغة مأخوذ من الجمع ومنه يقال أجمل الحساب إذا جمعه ورفع تفاصيله وقيل هو المحصل ومنه يقال جملت الشيء إذا حصلته هكذا ذكره صاحب المجمل في اللغة.
وأما في اصطلاح الأصوليين فقال بعض أصحابنا: هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء وهو فاسد فإنه ليس بمانع ولا جامع.
أما أنه ليس بمانع فلأنه يدخل فيه اللفظ المهمل فإنه لا يفهم منه شيء عند إطلاقه وليس بمجمل لأن الإجمال والبيان من صفات الألفاظ الدالة والمهمل لا دلالة له ويدخل فيه قولنا مستحيل فإنه ليس بمجمل مع أنه لا يفهم منه شيء عند إطلاقه لأن مدلوله ليس بشيء بالاتفاق.
وأما أنه ليس بجامع فلأن اللفظ المجمل المتردد بين محامل قد يفهم منه شيء وهو انحصار المراد منه في بعضها وإن لم يكن معيناً.
وكذلك ما هو مجمل من وجه ومبين من وجه كقوله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده " الأنعام 141 فإنه مجمل وإن كان يفهم منه شيء.
فإن قيل: المراد منه أنه الذي لا يفهم منه شيء عند إطلاقه من جهة ما هو مجمل ففيه تعريف المجمل بالمجمل وتعريف الشيء بنفسه ممتنع.
كيف وإن الإجمال كما أنه قد يكون في دلالة الألفاظ فقد يكون في دلالة الأفعال وذلك كما لو قام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية ولم يجلس جلسة التشهد الوسط فإنه متردد بين السهو الذي لا دلالة له على جواز ترك الجلسة وبين التعمد الدال على جواز تركها.
وإذا كان الإجمال قد يعم الأقوال والأفعال فتقييد حد المجمل باللفظ يخرجه عن كونه جامعاً وبهذا يبطل ما ذكره الغزالي في حد المجمل من أنه اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال.
وذكر أبو الحسين البصري فيه حدين آخرين: الأول أنه الذي لا يمكن معرفة المراد منه ويبطل بالألفاظ المهملة وباللفظ الذي هو حقيقة في شيء فإنه إذا أريد به جهة مجازه فإنه لا يفهم المراد منه وليس بمجمل.
الثاني قال: المجمل هو ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا بعينه قال وهذا بخلاف قولك اضرب رجلاً فإن مدلوله واحد غير معين في نفسه وأي رجل ضربته جاز ولا كذلك لفظ القرء فإن مدلوله واحد متعين في نفسه من الطهر أو الحيض وفيه إشعار بتقييد الحد باللفظ حيث قال: واللفظ لا بعينه فلا يكون جامعاً بخروج الإجمال في دلالة الفعل عنه كما حققناه وإنما يصح التقييد باللفظ لو أريد تحديد المجمل اللفظي خاصةً.
والحق في ذلك أن يقال: المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه.
فقولنا ما له دلالة ليعم الأقوال والأفعال وغير ذلك من الأدلة المجملة وقولنا على أحد أمرين احتراز عما لا دلالة له إلا على معنى واحد وقولنا لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه احتراز عن اللفظ الذي هو ظاهر في معنىً وبعيد في غيره كاللفظ الذي هو حقيقة في شيء ومجاز في شيء على ما عرف فيما تقدم.
وقد يكون ذلك في لفظ مفرد مشترك عند القائلين بامتناع تعميمه وذلك إما بين مختلفين كالعين للذهب والشمس والمختار للفاعل والمفعول أو ضدين كالقرؤ للطهر والحيض.
وقد يكون في لفظ مركب كقوله تعالى: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " البقرة فإن هذه متردة بين الزوج والولي.
وقد يكون ذلك بسبب التردد في عود الضمير إلى ما تقدمه كقولك: كل ما علمه الفقيه فهو كما علمه فإن الضمير في هو متردد بين العود إلى الفقيه وإلى معلوم الفقيه والمعنى يكون مختلفاً حتى أنه إذا قيل بعوده إلى الفقيه كان معناه: فالفقيه كمعلومه وإن عاد إلى معلومه كان معناه: فمعلومه على الوجه الذي علم.
وقد يكون ذلك بسبب تردد اللفظ بين جمع الأجزاء وجمع الصفات كقولك: الخمسة زوج وفرد والمعنى مختلف حتى أنه إن أريد به جمع الأجزاء كان صادقاً وإن أريد به جمع الصفات كان كاذباً.
وقد يكون ذلك بسببه الوقف والابتداء كما في قوله تعالى: " وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم " آل عمران 7 فالواو في قوله: " والراسخون مترددة بين العطف والابتداء والمعنى يكون مختلفاً.
وقد يكون ذلك بسبب تردد الصفة وذلك كما لو كان زيد طبيباً غير ماهر في الطب وهو ماهر في غيره فقلت زيد طبيب ماهر فإن قولك ماهر متردد بين أن يراد به كونه ماهراً في الطب فيكون كاذباً وبين أن يراد به غيره فيكون صادقاً.
وقد يكون ذلك بسبب تردد اللفظ بين مجازاته المتعددة عند تعذر حمله على حقيقته وقد يكون بسببه تخصيص العموم بصور مجهولة كما لو قال: اقتلوا المشركين ثم قال بعد ذلك بعضهم غير مراد لي من لفظي فإن قوله: " اقتلوا المشركين " بعد ذلك يكون مجملاً غير معلوم أو بصفة مجهولة كقوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين " النساء 24 فإن تقييد الحل بالإحصان مع الجهل بما هو الإحصان يوجب الإجمال فيما أحل أو باستثناء مجهول كقوله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم " المائدة 1 فإنه مهما كان المستثنى مجملاً فالمستثنى منه كذلك وكذلك الكلام في تقييد المطلق.
وقد يكون ذلك بسبب إخراج اللفظ في عرف الشرع عما وضع له في اللغة عند القائلين بذلك قبل بيانه لنا كقوله: " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " البقرة 43 " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " آل عمران 5 فإنه يكون مجملاً لعدم إشعار اللفظ بما هو المراد منه بعينه من الأفعال المخصوصة لأنه مجمل بالنسبة إلى الوجوب.
هذا كله في الأقوال وقد يكون ذلك في الأفعال كما ذكرناه أولاً.
وتمام كشف الغطاء عن ذلك بمسائل وهي ثمان : المسألة الأولى في أن التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان لا إجمال فيهما الذي صار إليه أصحابنا وجماعة من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار والجبائي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري أن التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان كقوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم النساء 23 " وحرمت عليكم الميتة " المائدة 3 لا إجمال فيه خلافاً للكرخي وأبي عبد الله البصري.
احتج القائلون بالإجمال بأن التحليل والتحريم إنما يتعلق بالأفعال المقدورة والأعيان التي أضيف إليها التحليل والتحريم غير مقدورة لنا فلا تكون هي متعلق التحليل والتحريم فلا بد من إضمار فعل يكون هو متعلق ذلك حذراً من إهمال الخطاب بالكلية ويجب أن يكون ذلك بقدر ما تندفع به الضرورة تقليلاً للإضمار المخالف للأصل.
وعلى هذا فيمتنع إضمار كل ما يمكن تعلقه بالعين من الأفعال وليس إضمار البعض أولى من البعض لعدم دلالة الدليل على تعيينه ولأنه لو دل على تعيين بعض الأفعال لكان ذلك متعينا من تعلق التحريم بأي عين كانت وهو محال.
قال النافون: وإن سلمنا امتناع تعلق التحليل والتحريم بنفس العين ولكن متى يحتاج إلى الإضمار إذا كان اللفظ ظاهراً بعرف الاستعمال في الفعل المقصود من تلك العين أو إذا لم يكن ؟الأول ممنوع والثاني مسلم.
وبيانه أن كل من اطلع على عرف أهل اللغة ومارس ألفاظ العرب لا يتبادر إلى فهمه عند قول القائل لغيره: حرمت عليك الطعام والشراب وحرمت عليك النساء سوى تحريم الأكل والشرب من الطعام والشراب وتحريم وطء النساء.
والأصل في كل ما يتبادر إلى الفهم أن يكون حقيقةً إما بالوضع الأصلي أو بعرف الاستعمال والإجمال منتف بكل واحد منهما ولهذا كان الإجمال منتفياً عند قول القائل: رأيت دابةً لما كان المتبادر إلى الفهم ذوات الأربع بعرف الاستعمال وإن كان على خلاف الوضع الأصلي وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ذكروه من الوجه الثاني أيضاً.
سلمنا أنه لا بد من الإضمار ولكن ما المانع من إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالعين المضاف إليها التحليل والتحريم.
قولهم إن زيادة الإضمار على خلاف الأصل قلنا: فإضمار البعض إما أن يفضي إلى الإجمال أو لا يفضي إليه فإن كان الثاني فقد بطل مذهبكم وإن كان يفضي إلى الإجمال فلا بد من إضمار الكل حذراً من تعطيل دلالة اللفظ.
فلئن قالوا: إضمار البعض وإن أفضى إلى الإجمال فليس في ذلك ما يفضي إلى تعطيل دلالة اللفظ مطلقاً لإمكان معرفة تعيين مدلوله بدليل آخر.
وأما محذور إضمار كل التصرفات فلازم مطلقاً ولا يخفى أن التزام المحذور الدائم أعظم من التزام المحذور الذي لا يدوم.
قلنا: بل التزام محذوره إضمار جميع الأفعال أولى من التزام محذور الإجمال في اللفظ لثلاثة أوجه: الأول: أن الإضمار في اللغة أكثر استعمالاً من استعمال الألفاظ المجملة ولولا أن المحذور في الإضمار أقل لما كان استعماله أكثر.
الثاني: أنه انعقد الإجماع على وجود الإضمار في اللغة والقرآن واختلف في وجود الإجمال فيهما وذلك يدل على أن محذور الإضمار أقل.
الثالث: أنه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها وذلك يدل على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم وإلا لما لحقهم اللعن ببيعها ولو كان الإجمال أولى من إضمار الكل لكان ذلك على خلاف الأولى.
المسألة الثانية ؟؟ذهب بعض الحنيفة إلى أن قوله تعالى:وامسحوا برؤسكم مجمل ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " المائدة 6 مجمل لأنه يحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل مسح بعضه وليس أحدهما أولى من الآخر فكان مجملاً.
قالوا: وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح بناصيته فهو بيان لمجمل الآية.
واتفق النافون على نفي الإجمال لكن منهم من قال إنه بحكم وضع اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس وهو مذهب مالك والقاضي عبد الجبار وابن جني مصيراً منهم إلى أن الباء في اللغة أصل في الإلصاق كما سبق تعريفه وقد دخلت على المسح وقرنته بالرأس واسم الرأس حقيقة في كله لا بعضه ولهذا ولا يقال لبعض الرأس رأس فكان ذلك مقتضياً لمسح جميعه لغةً.
وهذا وإن كان هو الحق بالنظر إلى أصل وضع اللغة غير أن عرف استعمال أهل اللغة الطارىء على الوضع الأصلي حاكم عليه والعرف من أهل اللغة في اطراد الاعتياد جار باقتضاء إلصاق المسح بالرأس فقط مع قطع النظر عن الكل والبعض.
ولهذا فإنه إذا قال القائل لغيره: امسح يدك بالمنديل لا يفهم منه أحد من أهل اللغة أنه أوجب عليه إلصاق يده بجميع المنديل بل بالمنديل إن شاء بكله وإن شاء ببعضه ولهذا فإنه يخرج عن العهدة بكل واحد منهما.
وكذلك إذا قال: مسحت يدي بالمنديل فالسامعون يجوزون أنه مسح بكله وببعضه غير فاهمين لزوم وقوع المسح بالكل أو البعض بل بالقدر المشترك بين الكل والبعض وهو مطلق مسح ويجب أن يكون كذلك نفياً للتجوز والاشتراك في العرف.
وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه واختيار القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري.
وعلى كل تقدير فلا وجه للقول بالإجمال لا بالنظر إلى الوضع اللغوي الأصلي ولا بالنظر إلى عرف الاستعمال.
المسألة الثالثة مذهب الجمهور أنه لا إجمال في قوله صلى الله عليه وسلم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " وقال أبو الحسين البصري وأبو عبد الله البصري وغيرهما إنه مجمل مصيراً منهم إلى أن اللفظ بوضعه لغة يقتضي رفع الخطإ والنسيان في نفسه وهو محال مع فرض وقوعه فيجل منصب النبي عن نفيه.
وعند ذلك فإما أن يضمر نفي جميع أحكامه أو بعضها لا سبيل إلى الأول لأن الإضمار على خلاف الأصل وإنما يصار إليه لدفع الضرورة اللازمة من تعطيل العمل باللفظ فيجب الاقتصار فيه على أقل ما تندفع به الضرورة وهو بعض الأحكام.
كيف وأنه يمتنع إضمار نفي جميع الأحكام لأن من جملتها لزوم الضمان وقضاء العبادة وهو غير منفي بالإجماع ثم ذلك الحكم المضمر لا يمكن القول بتعيينه لعدم دلالة اللفظ عليه فلم يبق إلا أن يكون غير معين ويلزم منه الإجمال.
قال النافون للإجمال: وإن تعذر حمل اللفظ على رفع عين الخطإ والنسيان فإنما يلزم الإضمار إن لو لم يكن اللفظ ظاهراً بعرف استعمال أهل اللغة في نفي المؤاخذة والعقاب قبل ورود الشرع وليس كذلك.
ولهذا فإن كل من عرف عرف أهل اللغة لا يتشكك ولا يتردد عند سماعه قول السيد لعبده: رفعت عنك الخطأ والنسيان في أن مراده من ذلك رفع المؤاخذة والعقاب.
والأصل أن كل ما يتبادر إلى الفهم من اللفظ أن يكون حقيقة فيه إما بالوضع الأصلي أو العرف الاستعمالي وذلك لا إجمال فيه ولا تردد.
فإن قيل: لو كان عرف الاستعمال كما ذكرتموه لارتفع عنه الضمان لكونه من جملة المؤاخذات والعقوبات.
قلنا: عنه جوابان: الأول: أنا نسلم أن الضمان من حيث هو ضمان عقوبة ولهذا يجب في مال الصبي والمجنون وليسا أهلاً للعقوبة وكذلك يجب على المضطر في المخمصة إذا أكل مال غيره مع أن الأكل واجب عليه حفظاً لنفسه والواجب لا عقوبة على فعله وكذلك يجب الضمان على من رمى إلى صف الكفار فأصاب مسلماً مع أنه مأمور بالرمي وهو مثاب عليه.
الثاني: وإن سلمنا أنه عقاب لكن غايته لزوم تخصيص عموم اللفظ الدال على نفي كل عقاب وذلك أسهل من القول بالإجمال.
المسألة الرابعة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة إلا بطهور " فمذهب الكل إنه لا اجمال فيه اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ونحوه.
فمذهب الكل أنه لا إجمال فيه خلافاً للقاضي أبي بكر وأبي عبد الله البصري فإنهما قالا بإجماله لأن حرف النفي دخل على هذه المسميات مع تحققها فلا بد من إضمار حكم يلحق وتمام تقريره كما مر في المسألة المتقدمة.
والمختار أنه لا إجمال في هذه الصور لأنه لا يخلو إما أن يقال بأن الشارع له في هذه الأسماء عرف أو لا عرف له فيها بل هي منزلة على الوضع اللغوي.
فإن قيل بالأول: فيجب تنزيل كلام الشارع على عرفه إذ الغالب منه أنه إنما يناطقنا فيما له فيه عرف بعرفه فيكون لفظه منزلاً على نفي الحقيقة الشرعية من هذه الأمور ونفي الحقيقة الشرعية ممكن.
والأصل حمل الكلام على ما هو حقيقة فيه وعلى هذا فلا إجمال وإن كان مسمى هذه الأمور بالوضع اللغوي غير منفي.
وإن قيل بالثاني: فالإجمال أيضاً إنما يتحقق إن لو لم يكن اللفظ ظاهراً بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع في مثل هذه الألفاظ في نفي الفائدة والجدوى وليس كذلك.
وبيانه أن المتبادر إلى الفهم من نفي كل فعل كان متحقق الوجود إنما هو نفي فائدته وجدواه ومنه قولهم لا علم إلا ما نفع ولا كلام إلا ما أفاد ولا حكم إلا لله ولا طاعة إلا له ولا بلد إلا بسلطان إلى غير ذلك.
وإذا كان النفي محمولاً على نفي الفائدة والجدوى فلا إجمال فيه وإن سلمنا أنه لا عرف للشارع ولا لأهل اللغة في ذلك وأنه لا بد من الإضمار غير أن الاتفاق واقع على أنه لا خروج للمضمر هاهنا عن الصحة والكمال وعند ذلك فيجب اعتقاد ظهوره في نفي الصحة والكمال لوجهين: الأول: أنه أقرب إلى موافقة دلالة اللفظ على النفي لأنه إذا قال: لا صلاة لا صوم إلا بكذا فقد دل على نفي أصل الفعل بدلالة المطابقة وعلى صفاته بدلالة الالتزام فإذا تعذر العمل بدلالة المطابقة تعين العمل بدلالة الالتزام تقليلا لمخالفة الدليل.
الثاني: أنه إذا كان اللفظ قد دل على نفي العمل وعدمه فيجب عند تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمله على أقرب المجازات الشبيهة به ولا يخفى أن مشابهة الفعل الذي ليس بصحيح ولا كامل للفعل المعدوم أكثر من مشابهة الفعل الذي نفي عنه أحد الأمرين دون الآخر فكان الحمل عليه أولى.
فإن قيل ما ذكرتموه معارض من وجهين: الأول أنه يلزم منه الزيادة في الإضمار والتجوز المخالف للأصل الثاني أن حمله على نفي الكمال دون الصحة مستيقن من حيث إنه يلزم من نفي الصحة نفي الكمال ولا عكس وإذا تقابلت الاحتمالات لزم الإجمال.
قلنا: بل الترجيح لما ذكرناه لأنه لا يلزم منه تعطيل دلالة اللفظ بخلاف ما ذكرتموه ولأنه على وفق النفي الأصلي وما ذكرتموه على خلافه فكان ما ذكرناه أولى.
وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم: " لا عمل إلا بنية وإنما الأعمال بالنيات " وإن لم يكن للشارع فيه عرف كما في الصلاة والصوم ونحوهما فعرف أهل اللغة في نفيه نفي الفائدة والجدوى كما قررناه فيما تقدم فلا إجمال فيه أيضاً خلافاً لأبي الحسين البصري وأبي عبد الله البصري وغيرهما من المعتزلة.
المسألة الخامسة اختلفوا في قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما هل هو مجمل أم لا ؟ اختلفوا في قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " المائدة 38 فقال بعض الأصوليين إن لفظ القطع واليد مجمل.
أما الإجمال في القطع فلأنه يصدق إطلاقه على بينونة العضو من العضو وعلى شق الجلد الظاهر من العضو بالجرح من غير إبانة للعضو.
ولذلك يقال عندما إذا جرح يده في بعض الأعمال كبرى القلم وغيره قطع يده وأما الإجمال في اليد فلأن لفظ اليد يطلق على جملتها إلى المنكب وعليها إلى المرفق وعليها إلى الكوع وليس أحد هذه الاحتمالات أظهر من الآخر فكان لفظ اليد والقطع مجملاً.
وذهب الباقون إلى خلافه متمسكين في ذلك بالإجمال والتفصيل : أما الإجمال فهو أن إطلاق لفظ اليد على ما ذكر من المحامل وكذلك إطلاق لفظ القطع إما أن يكون حقيقةً في الكل أو هو حقيقة في البعض مجاز في البعض فإن كان حقيقة في الكل فإما أن يكون مشتركاً أو متواطئاً: القول بالاشتراك يلزم منه الإجمال في الكلام وهو على خلاف الأصل وإن كان الثاني والثالث فليس بمجمل.
كيف وإنه وإن كان الاشتراك على وفق الأصل إلا أن الاحتمالات ثلاثة كما ذكرناه ولا إجمال فيه على تقديرين منها وهما حالة التواطؤ والتجوز في أحدهما وإنما يتحقق الإجمال على تقدير الاشتراك وهو متحد ووقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه.
وإذا كان حقيقة في أحدهما دون الآخر فيجب اعتقاد كونه ظاهراً في كل العضو ضرورة الاتفاق على عدم ظهوره فيما سواه أما عند الخصم فلدعواه الإجمال وأما عندنا فلمصيرنا إلى نفي الظهور عنه وانحصاره في جملة مسمى العضو.