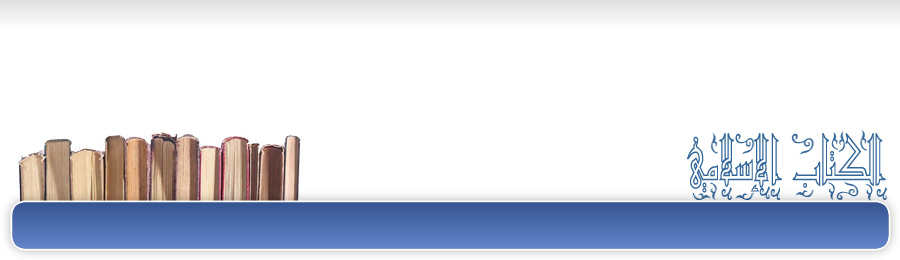كتاب : المحصول في علم الأصول
المؤلف : محمد بن عمر بن الحسين الرازي
أن يكون متمكنا من استدراكه فلأجل هذا شرعنا استثناء الأقل من الأكثر ولم يوجد هذا المعنى في استثناء المثل أو الأكثر لما ذكرنا أن الكثرة مظنة الذكر
وإذا ظهر الفارق بقي المقتضي سليما عن المعارض
والجواب عندنا
أن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على ذلك القدر وعلى هذا الفرض يسقط ما ذكرتم والله أعلمالمسألة الخامسة
الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثباتمثال الأول قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ومثال الثاني قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك
وزعم أبو حنيفة رحمه الله أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا قال لأن بين الحكم بالنفي وبين الحكم بالإثبات واسطة وهي عدم الحكم
فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات
لنا
لو لم يكن الاستثناء في النفي إثباتا لما كان قولنا لا إله إلا الله موجبا ثبوت الإلهية لله جل جلاله بل كان معناه نفي ألإلهية عن غيره وأما ثبوت الإلهية له فلا ولو كان كذلك لما تم الإسلام ولما كان ذلك باطلا علمنا أنه يفيد الإثبات
احتج أبو حنيفة رحمه الله بقوله صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي و لا صلاة إلا بطهور ولم يلزم منه تحقق النكاح عند حضور الولي
ولا تحقق الصلاة عند حضور الوضوء بل يدل على عدم صحتهما عند عدم هذين الشرطين والله أعلم
المسألة السادسة
الاستثناآت إذا تعددت فإن كان البعض معطوفا على البعض بحرف العطف كان الكل عائدا إلى المستثنى منه كقولك لفلان عندي عشرة إلا أربعة وإلا خمسةوإن لم يكن كذلك فالاستثناء الثاني إن كان أكثر من الأول أو مساويا له عاد إلى الأول كقوله لفلان علي عشرة إلا أربعة إلا خمسة
وإن كان أقل من الأول كقولك لفلان علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة فالاستثناء الثاني إما أن يكون عائدا إلى الاستثناء الأول فقط أو إلى المستثنى
منه فقط أو إليهما معا أولا إلى أحد منهما
والأول هو الحق
والثاني باطل لأن القريب إن لم يكن أولى من البعيد فلا أقل من المساواة
والثالث أيضا باطل لوجهين
أحدهما
أن المستثنى منه مع الاستثناء ألأول لا بد وأن يكون أحدهما نفيا والآخر إثباتا فالاستثناء الثاني لو عاد إليهما معا والاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فيكون الاستثناء الثاني قد نفى عن أحد الأمرين السابقين عليه ما أثبته للآخر فينجبر النقصان بالزيادة ويبقى ما كان حاصلا قبل الاستثناء الثاني فيصير الاستثناء الثاني لغواوثانيهما
أن الاستثناء الثاني لو رجع إلى الاستثناء الأول والمستثنى منه معا لزم أن يكون نفيا وإثباتا معا وهو محال فإن قلت النفي والإثبات إنما يتنافيان لو رجعا إلى شيء واحد من وجه واحد فأما عند رجوعهما إلى شيئين فلا يتنافيان
قلت لنفرض أنه قال علي عشرة إلا اثنين إلا واحدا فالاستثناء الثاني لما رجع إلى المستثنى منه أخرج منه درهما آخر ولما رجع إلى الاستثناء الأول اقتضى ذلك إثبات ذلك الدرهم المستثنى منه فيكون ذلك الاستثناء نفيا وإثباتا من المستثنى منه وهو محال
أما الرابع وهو أن لا يرجع الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأول ولا إلى المستثنى منه فهو باطل بالاتفاق
المسألة السابعة
الاستثناء المذكور عقيب جمل كثيرة هل يعود إليها باسرها أم لا مذهب الشافعي رضي الله عنه وأصحابه عوده إلى الكلومذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه اختصاصه بالجملة الأخيرة
وذهب القاضي منا والمرتضى من الشيعة إلى التوقف إلا أن المرتضى توقف للاشتراك والقاضي لم يقطع بذلك أيضا ومنهم من فصل القول فيه وذكروا وجوها
وأدخلها في التحقيق ما قيل إن الجملتين من الكلام إما أن يكونا من نوع واحد أو يكونا من نوعين
فإن كان الأول فإما أن تكون إحدى الجملتين متعلقة بالأخرى أو لا تكون كذلك
فإن كان الثاني فإما أن يكونا مختلفي الاسم والحكم أو متفقي الاسم مختلفي الحكم أو مختلفي الاسم متفقي الحكم
فالأول كقولك أطعم ربيعة واخلع على مضر إلا الطوال
والأظهر ها هنا اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة لأن الظاهر أنه لم ينتقل من الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة
أخرى مستقلة بنفسها إلا وقد تم غرضه من الجملة الأولى ولو كان الاستثناء راجعا إلى جميع الجمل لم يكن قد تم مقصوده من الجملة الأولى
وأما الثاني فكقولنا أطعم ربيعة واخلع على ربيعة إلا الطوال
وأما الثالث فكقولنا أطعم ربيعة وأطعم مضر إلا الطوالوالحكم ها هنا أيضا كما ذكرنا لأن كل واحدة من الجملتين مستقلة فالظاهر أنه لم ينتقل من إحداهما إلا وقد تم غرضه بالكلية منها
وأما إن كانت أحدى الجملتين متعلقة بالأخرى فإما أن يكون حكم الأولى مضمرا في الثانية كقوله أكرم ربيعة ومضر إلا الطوال أو اسم الأولىمضمرا في الثانية كقوله أكرم ربيعة واخلع عليهم إلا الطوال فالاستثناء في هذين القسمين راجع إلى الجملتين لأن الثانية لا تستقل إلا مع الأولى فوجب رجوع حكم الاستثناء إليهما
وأما إن كانت الجملتان نوعين من الكلام فإما أن تكون القضية واحدة أو مختلفة
فإن كانت مختلفه فهو كقولنا أكرم ربعة والعلماء هم المتكلمون إلا أهل البلدة الفلانية فالاستثناء فيه يرجع إلى ما يليه لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها
وأما إن كانت القضية واحدة فهو كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات فالقضية واحدة وأنواع الكلام مختلفة فالجملة الأولى أمر والثانية نهي والثالثة خبر فالاستثناء فيها يرجع إلى الجملة الأخيرة لاستقلال كل واحدة في تلك الجمل بنفسها
والإنصاف أن هذا التقسيم حق لكنا إذا أردنا المناظرة اخترنا التوقف لا بمعنى دعوى الاشتراك بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا وهذا هو اختيار القاضي
واحتج الشافعي رضي الله عنه بوجوه
أولهاأن الشرط متى تعقب جملا عاد إلى الكل فكذا الاستثناء و الجامع أن كل واحد منهما لايستقل بنفسه
وأيضا فمعناهما واحد لأن قوله تعالى في آية القذف إلا الذين تابوا
جار مجرى قوله وأولئك هم الفاسقون إن لم يتوبوا
ويقرب من هذا الدليل قولهم أجمعنا على أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى عائد إلى كل الجمل فالاستثناء بغير المشيئة يجب ان يكون كذلك
وثانيها
أن حرف العطف يصير الجمل المعطوف بعضها على بعض في حكم الجملة الواحدة لأنه لا فرق بين أن تقول رأيت بكر بن خالد وبكر بن عمرو وبين أن تقول رأيت البكرين وإذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا إليها فكذا ما صار بحكم العطف كالجملة الواحدةوثالثها
أنه تعالى لو قال فاجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تابوا ولا تقبلوالهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون ( إلا الذين تابوا ) لكان ركيكا جدا
فبتقدير أن يريد الاستثناء عن كل الجمل لا طريق له إلى ذلك إلا بذكر الاستثناء عقيب الجملة الأخيرة ففي هذه الصورة يكون الاستثناء راجعا إلى كل الجمل والأصل في الكلام الحقيقة
وإذا ثبت كونه حقيقة في هذه الصورة كان كذلك في سائر الصور دفعا للاشتراك
ورابعها
لو قال لفلان علي خمسة وخمسة إلا سبعة كان الاستثناء ها هنا عائدا إلى الجملتين والأصل في الكلام الحقيقةوإذا ثبت ذلك في هذه الصورة فكذا في غيرها دفعا للاشتراك
واحتج أبو حنيفة رحمة الله عليه بوجوه
أحدهاأن الدليل ينفي اعتبار الاستثناء تركنا العمل به في الجملة الواحدة فيبقى العمل بالباقي في سائر الجمل
بيان النافي أن الاستثناء يقتضي إزالة العموم عن ظاهره وهو خلاف الأصل
بيان الفارق أن الاستثناء لا استقلال له بالدلالة على الحكم فلا بد من تعليقه بشيء لئلا يصير لغوا وتعليقه بالجملة الواحدة يكفي في خروجه عن اللغوية فلا حاجة إلى تعليقه بسائر الجمل
وإذا ثبت النافي والفارق ثبت أنه لا يجوز عوده إلى الجمل الكثيرة والخصم قال به فصار محجوجا
يبقى أن يقال لم خصصتموه بالجملة الأخيرة فتقول هذا تفريع قولنا ولنا فيه وجهان
الوجه الأول اتفاق أهل اللغة على أن للقرب تأثيرا في هذا المعنى ثم يدل
عليه أمور أربعةالأول
اتفاق أهل اللغة البصريين على أنه إذا اجتمع على المعمول الواحد عاملان فإعمال الأقرب أولى
الثاني
أنهم قالوا في ضرب زيد عمروا وضربته إن هذه الهاء بأن ترجع إلى عمرو المضروب أولى من أن ترجع إلى زيد الضارب للقربالثالث
أنهم قالوا في قولنا ضربت سلمى سعدى إنه ليس في إعراب اللفظ ولا في معناه ما يجعل أحدهما بالفاعلية اولى من الآخر فاعتبروا المجاورة فقالوا الذي يلي الفعل أولى بالفاعليةالرابع
أنهم قالوا في قولهم أعطى زيد عمروا بكرا أنه لما احتمل أن يكون وكل واحد من عمر وبكر مفعولا أول وليس في اللفظ ما يقتضي الترجيح وجب اعتبار القرب
الوجه الثاني
أن كل من صرف الاستثناء إلى جملة واحدة خصصه بالجملة الأخيرة فصرفه إلى غيرها خرق للإجماع فهذا تمام هذه الحجةوثانيهما
أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل لو رجع إلى جميعها لم يخل إما أن يضمر مع كل جملة استثناء يعقبها أولا يضمر ذلك بل الاستثناء المصرح به في آخر الجمل هو الراجع إلى جميعهاوالأول باطل لأن الإضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة ولا ضرورة ها هنا
والثاني أيضا باطل لأن العامل في نصب ما بعد حرف
الاستثناء هو ما قبله من فعل أو تقدير فعل فإذا فرضنا رجوع ذلك الاستثناء إلى كل الجمل كان العامل في نصب المستثنى أكثر من واحد لكن لا يجوز أن يعمل عاملان في إعراب واحد
أما أولا فلأن سيبويه نص عليه وقوله حجة
وأما ثانيا فلأنه يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان وهو محالوثالثها
أن الاستثناء من الاستثناء مختص بما يليهفكذا في سائر الصور دفعا للاشتراك عن الوضع
ورابعها
أن الجمل إذا كان كل واحد منها مستقلا بنفسه فالظاهر أنه لم ينتقل عن واحد منها إلى غيره إلا إذا تم غرضه منه لأنه كما أن السكوت يدل على استكمال الغرض المطلوب من الكلام فكذا الشروع في كلام آخر لا تعلق له بالأول يدل على استكمال الغرض من ذلك الأولإذا ثبت هذا فلو حكمنا برجوع الاستثناء ألى كل الجمل المتقدمة نقض ذلك قولنا إنه لما انتقل عن الكلام الأول تم غرضه
واحتج الشريف المرتضى على الاشتراك بوجوه
أحدها
أن القائل إذا قال اضرب غلماني وأكرم جيرانيإلا واحدا جاز أن يستفهم المخاطب هل أراد استثناء الواحد من الجملتين أو من الجملة الواحدة والاستفهام دليل الاشتراك
وثانيها
أنا وجدنا الاستثناء في القرآن والعربية تارة عائدا إلى كل الجمل وأخرى مختصا بالأخيرة وظاهر الاستعمال دليل الحقيقة فوجب الاشتراكوثالثها
أن القائل إذا قال ضربت غلماني وأكرمت جيرانيقائما أو في الدار أو يوم الجمعة احتمل فيما ذكره من الحال والظرفين أن يكون المتعلق به جميع الآفعال وأن يكون ما هو أقرب والعلم باحتمال الأمرين من مذهب أهل اللغة ضروري فإذا صح ذلك في الحال والظرفين صح أيضا في الاستثناء والجامع أن كل واحد منهما فضلة تأتي بعد تمام الكلام فهذا مجموع أدلة القاطعين
أما أدلة الشافعية فالجواب عن الأول
أن نمنع الحكم في الأصل وبتقدير تسليمه فنطالب بالجامعقوله إنهما يشتركان في عدم الاستقلال واقتضاء التخصيص قلنا لا يلزم من اشتراك شيئين في بعض
الوجوه اشتراكهما في كل الاحكام
قوله ثانيا معنى الشرط والاستثناء واحد
قلنا إن ادعيتم أنه لا فرق بينهما أصلا كان قياس أحدهما على الآخر قياسا للشيء على نفسه
وإن سلمتم الفرق طالبناكم بالجامع
وبهذين الجوابين نجيب عن الاستدلال بمشيئة الله تعالى
والجواب عن الثاني
أنكم إن ادعيتم أنه لا فرق بين الجملة الواحدة وبين الجمل المعطوف بعضها على بعض كان قياس أحدهما على الآخر قياسا للشيء على نفسه وإن سلمتم الفرق طالبناكم بالجامعوعن الثالث
أنه يمكن رعاية الاختصار بذكر الاستثناءالواحد عقيب الجمل مع التنبيه على ما يقتضي عوده إلى الكل وذلك لا يقدح في الفصاحة
وعن الرابع
أن هناك إنما رجع إلى الجملتين لأنه لا بد من اعتبار كلام العاقل ولما تعذر رجوعه إلى الجملتين وجب رجوعه إليهما وهذه الضرورة غير حاصلة في سائر المواضعوأما أدلة الحنفية فالجواب عن الآول من وجهين
أحدهماأنه ينتقض بالاستثناء بمشيئة الله تعالى وبالشرط فإن ذلك غير مستقل بنفسه مع أنهما يعودان إلى كل الجمل عندهم
فإن قلت الفرق هو أن الشرط وأن تأخر صورة فهو متقدم معنى وإذا كان متقدما معنى صار كل ما جاء بعده مشروطا به
وأما الاستثناء بالمشيئة فإنه يقتضي صيرورة الكلام بأسره موقوفا فلا يختص بالبعض دون البعض
قلت لا نسلم أن الشرط يجب أن يكون مقدما على الكل بل يجوز أن يكون مقدما على الجملة الأخيرة
وإن سلمنا ذلك فلا نسلم أن التقدم يقتضي الرجوع إلى الكل بل لعله يكون مختصا بما يليه
وأما الاستثناء بالمشيئة فلم لا يجوز أن لا يقتضي كون الكل موقوفا بل يختص ذلك بالجملة الأخيرة
والأصوب للحنفية أن يمنعوا هذين الإلزامين حتى يتم دليلهم
وثانيهما
أنا لا نسلم أن الاستثناء على خلاف الأصلقوله لأنه يوجب صرف العموم عن ظاهره
قلنا لا نسلم لأنا بينا في مسئلة أن العام المخصوص بالاستثناء لا يكون مجازا وأن لفظ العموم مع لفظ الاستثناء يصير كاللفظ الواحد الدال على ما بقي بعد الاستثناء
وعلى هذا التقدير لا يكون الاستثناء على خلاف الأصل
وعن الثاني
أنا لا نسلم أنه لا يجوز أن يجتمع على المعمول الواحد عاملان ونص سيبويه علىأنه لا يجوز معارض بنص الكسائي على أنه يجوز وقوله يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان فجوابه أن العوامل الإعرابية معرفات لا مؤثرات واجتماع المعرفين على الواحد غير ممتنعوعن الثالث
أن الاستثناء من الاستثناء لو عاد إليه وإلى المستثنى معالزم الفسادان المذكوران فيما تقدم وذلك غير حاصل في الاستثناء من الجمل
وعن الرابع
أن نقول ما تريدون بقولكم إنه لم ينتقل عن إحدى الجملتين إلى غيرها إلابعد فراغه من الأولىإن عنيتم به أنه لم ينتقل منها إلى غيرها إلا بعد فراغه من جميع أحكام الآولى فهذا ممنوع بل هو أول المسألة لأن عندنا من جملة أحكامها ذلك الاستثناء الذي ذكرتموه في آخر الجمل
وإن عنيتم شيئا آخر فاذكروه لننظر فيه
وأما أدلة الشريف المرتضى
فالجواب عن الأول والثاني منها ما تقدم في باب العموموعن الثالث
أنا لا نسلم التوقف في الحال والظرفين بل نخصهما بالجملة الأخيرة على قول أبي حنيفة رحمه الله أو بالكل على قول الشافعي رضي الله عنهسلمنا التوقف لكن لا على سبيل الاشتراك بل على سبيل أنا لا ندري أن الحق ما هو عند أهل اللغه
فإن تمسك على الاشتراك بالاستفهام والاستعمال كان ذلك منه عودا إلى الطريقتين الأوليين
سلمناه فلم قلتم إنه يجب أن يكون الأمر كذلك في الاستثناء قوله الجامع هو كون كل واحد من هذه الثلاثة فضلة تأتي بعد تمام الكلام
قلنا الاشتراك من بعض الوجوه لا يقتضي التساوي من جميع الوجوه والله أعلم
الباب الثاني في التخصيص بالشرط وفيه مسائل
المسألة الأولى
الشرط هو الذي يقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاته ولا ترد عليه العلة لأنها نفس المؤثر والشيء لا يقف على نفسه ولا جزء العلة ولا شرط ذاتها لأن العلة تقف عليه في ذاتهاثم الشرط قد يكون عقليا وهو معلوم
وقد يكون شرعيا فهذا هو الشرط الشرعي وهو كالإحصان فإنه شرط اقتضاء الزنا لوجوب الرجم
المسألة الثانية
صيغة الشرط إن و إذا وهما بعد الاشتراك في كون كل واحد منهما صيغة الشرط يفترقان في أن إن تدخل على المحتمل لا على المتحقق و إذا تدخل عليهما تقول أنت طالق إذا احمر البسر وإن دخلت الدار فالأول محقق والثاني محتمل ولا تقول أنت طالق إن احمر البسر إلا إذا لم يتيقن ذلك
المسألة الثالثة
في ان المشروط متى يحصلوذلك يستدعي مقدمة وهي أن الشرط على أقسام ثلاثة
أحدها
الذي يستحيل أن يدخل في الوجود إلا دفعة واحدة بتمامه سواء كان ذلك لأنه في نفسه واحد لا تركيب فيه أو إن كان مركبا لكن يستحيل أن يدخل شيء من أجزائه في الوجود إلا مع الآخروثانيها
ما يستحيل أن يدخل بجميع أجزائه في الوجود كالكلاموالحركة فإن المتكلم بلفظة يكون حينما وجد الحرف الأول منها لا يكون الثاني حاصلا وحين حصل الثاني صار الأول فانيا
وثالثها
ما يصح أن يدخل في الوجود تارة بمجموعه وتارة بتعاقب أجزائهثم نقول على هذه التقديرات الثلاثة فالشرط إما عدمها وإما وجودها
فإن كان الشرط عدمها حصل الحكم في الآقسام الثلاثة في أول زمان عدمها
وإن كان الشرط وجودها فنقول أما في القسم الأول فالحكم يحصل مقارنا لأول زمان وجود الشرط
وأما في القسم الثاني فإنه يحصل عند حصول آخر جزء من أجزاء الشرط في الوجود لأنه ليس لذلك المجموع وجود في التحقيق بل أهل العرف يحكمون عليه بالوجود وإنما يحكمون عليه بذلك عند دخول آخر جزء من أجزائه في الوجود والحكم كان معلقا على وجوده فوجب أن يحصل الحكم في ذلك الوقت
وأما في القسم الثالث فنقول وجوده حقيقة إنما يتحقق عند دخول جميع أجزائه في الوجود دفعة واحدة لكنا في القسم الثاني عدلنا عن هذه الحقيقة للضرورة وهي مفقودة في هذا القسم فوجب اعتبار الحقيقة حتى إنه إن حصل
مجموع أجزائها دفعة واحدة ترتب الجزاء عليه وإلا فلا
هذا مقتضى البحث الأصولي اللهم إلا إذا قام دليل شرعي على العدول عنه
المسألة الرابعة
الشرطان إذا دخلا على جزاء فإن كانا شرطين على الجمع لم يحصل المشروط إلا عند حصولهما معا وهو كقوله إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالقولو رتب عليهما جزاءين كان كل واحد من الشرطين معتبرا في كل واحد من الجزاءين لا على التوزيع بل على سبيل الجمع
وإن كانا على سبيل البدل كان كل واحد منهما وحده كافيا في الحكم كقولك إن دخلت الدار أو كلمت زيدا
المسألة الخامسة
الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين فإما أن يدخل عليهما على سبيل الجمع أو على سبيل البدلفالأول كقولك إن زنيت جلدتك ونفيتك ومقتضاه حصولهما معا
والثاني كقولك إن زنيت جلدتك أو نفيتك ومقتضاه أحدهما مع أن التعيين فيه إلى القائل والله أعلم
المسألة السادسة
اختلفوا في أن الشرط الداخل على الجمل هل يرجع حكمه إليها بالكليةفاتفق الإمامان الشافعي وأبو حنيفة رحمة الله عليهما على رجوعه إلى الكل 3 وذهب بعض الأدباء إلى أنه يختص بالجملة التي تليه حتى إنه إن كان متأخرا اختص بالجملة الأخيرة
وإن كان متقدما اختص بالجملة الأولى
والمختار التوقف كما في مسئلة الاستثناء
المسألة السابعة
اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام ودليله ما مر في الاستثناءواتفقوا على أنه يحسن التقييد بشرط أن يكون الخارج أكثر من الباقي وإن اختلفوا فيه في الاستثناء
المسألةالثامنة
لانزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره إنما النزاع في الأولىويشبه أن يكون الأولى هو التقديم خلافا للقراء
لنا
أن الشرط متقدم في الرتبة على الجزاءلأنه شرط تأثير المؤثر فيه وما يستحق التقديم طبعا يستحق التقديم وضعا والله أعلم
الباب الثالث
في تخصيص العام بالغاية والصفة
وفيه فصلان
الفصل الأول في تقييد العام بالغاية وفيه أبحاث
البحث الأولأن غاية الشيء نهايته وطرفه ومقطعه
الثاني
ألفاظها وهي حتى وإلى كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقوله وأيديكم إلى المرافقالثالث
التقييد بالغاية يقتضي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية بخلاف الحكم فيما قبلها لأن الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم يكن العام منقطعا فلم تكن الغاية غايةوالأولى أن يقال الغاية إما أن تكون منفصلة عن ذي الغاية بمفصل معلوم كما في قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل أو لا تكون كذلك كقوله
تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فإن المرفق غير منفصل عن اليد بمفصل محسوس
أما القسم الأول فيجب أن يكون حكم ما بعد الغاية بخلاف حكم ما قبله لأن
انفصال أحدهما عن الآخر معلوم بالحسوأما الثاني فلا يجب أن يكون حكم ما بعده بخلاف ما قبله لأنه لما لم يكن المرفق منفصلا عن اليد بمفصل معلوم معين لم يكن تعيين بعض المفاصل لذلك أولى من بعض فوجب من ها هنا دخول ما بعده فيما قبله
الرابع
يجوز اجتماع الغايتين كما لو قيل لا تقربوهن حتى يطهرن وحتى يغتسلن فهاهنا الغاية في الحقيقة هي الأخيرة وعبر عن الأول بها لقربه منها واتصاله بها
الفصل الثاني
في تقييد العام بالصفةوالصفة إما أن تكون مذكورة عقيب شيء واحد كقولنا رقبة مؤمنه ولا شك في عودها إليه
أو عقيب شيئين وها هنا إما أن يكون أحدهما متعلقا بالآخر كقولك أكرم العرب والعجم المؤمنين فها هنا الصفة تكون عائدة إليهما
وإما أن لا تكون كذلك كقولك أكرم العلماء وجالس
الفقهاء الزهاد فها هنا الصفةعائدة إلى الجملة الأخيرة وأن كان للبحث فيه مجال كما في الاستثناء والشرط والله أعلم
القول في تخصيص العام بالأدلة المنفصلة
فنقول
تخصيص العام إماأن يكون بالعقل أو بالحس أو بالدلائل السمعية
وهو على وجهين
تخصيص المقطوع بالمقطوعوتخصيص المقطوع بالمظنون
فلنعقد في كل واحد فصلا
الفصل الأول في تخصيص العموم بالعقل
هذا قد يكون بضرورة العقل كقوله تعالى الله خالق كل شيء فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسهوبنظر العقل كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإنا نخصص الصبي والمجنون لعدم الفهم في حقهما
ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل والأشبه عندي أنه لا خلاف في المعنى بل في اللفظ
أما أنه لا خلاف في المعنى فلأن اللفظ لما دل على ثبوت الحكم في جميع الصور والعقل منع من ثبوته في بعض الصور فإما أن نحكم بصحة مقتضى العقل والنقل فيلزم صدق النقيضين وهو محال
أو نرجح النقل على العقل وهو محال لأن العقل أصل النقل فالقدح في العقل قدح في أصل النقل والقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا
وأما أن نرجح حكم العقل على مقتضى العموم وهذا هو مرادنا من تخصيص العموم بالعقل
وأما البحث اللفظي فهو أن العقل هل يسمى مخصصا أم لا
فنقول إن أردنا بالمخصص الأمر الذي يؤثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته فالعقل غير مخصص لأن المقتضي
لذلك الاختصاص هو الإرادة القائمة بالمتكلم والعقل يكون دليلا على تحقق تلك الإرادة فالعقل يكون دليل المخصص لا نفس المخصص ولكن على هذا التفسير وجب أن لا يكون الكتاب مخصصا للكتاب ولا السنة للسنة لأن المؤثر في ذلك التخصيص هو الإرادة لا تلك الآلفاظ
فإن قيل لو جاز التخصيص بالعقل فهل يجوز النسخ به
قلنا نعم لأن من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك إنما عرف بالعقل
الفصل الثاني في التخصيص بالحس
وهو كما في قوله تعالى وأوتيت من كل شيء فإنه لم يكن شيء من السماء والعرش والكرسي في يدها
الفصل الثالث في تخصيص المقطوع بالمقطوع وفيه مسائل
المسألة الأولىفي تخصيص الكتاب بالكتاب وهو جائز خلافا لبعض أهل الظاهر
لنا
إن وقوعه دليل جوازه لأن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مع قوله تعالى وأولات الآحمال أجلهن أن يضعن حملهن وكذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن مع قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب لا يخلو إما أن نجمع بين دلالة العام على عمومه والخاص على خصوصه وذلك محالوإما أن نرجح أحدهما على الآخر وحينئذ زوال الزائل إن كان على سبيل التخصيص فقد حصل الغرض وإن كان بالنسخ فقد حصل الغرض أيضا لآن كل من جوز نسخ الكتاب بالكتاب جوز تخصيصه به أيضا
احتجوا بقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم فوض
البيان إلى الرسول عليه الصلاة و السلام فوجب أن لا يحصل البيان إلا بقوله
والجواب
أنه معارض بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولأن تلاوة النبي صلى الله عليه و سلم آية التخصيص بيان منه له والله أعلم
المسألة الثانية
في تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة وهو جائز أيضا لأن العام والخاص مهما اجتمعا فإما أن يعمل بمقتضاهما أو يترك العمل بهما أو يرجح العام على الخاصوهذه الثلاثة باطلة بالإجماع فلم يبق إلا تقديم الخاص على العام
المسألة الثالثة
تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان أو فعلا جائز للدليل الذي مروأيضا قد وقع ذلك
أما بالقول فلأنهم خصصوا عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بقوله صلى الله عليه و سلم القاتل لا يرث وقوله ص
لا يتوارث أهل ملتين
وأما بالفعل فلأنهم خصصوا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة بما تواتر عنه صلى الله عليه و سلم من رجم المحصن
وأيضا تخصيص السنة المتواترة بالكتاب جائز
وعن بعض فقهائنا أنه لا يجوز ودليله التقسيم الذي مر
المسألة الرابعة
في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع وهو جائز لأنه واقع فإنهم خصصوا آية الإرث بالإجماع على أن العبد لا يرث وخصصوا آية الجلد بالإجماع على أن العبد كالأمة في تنصيف الحدوأما تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة المتواترة ف إنه غير جائز للإجماع ولأن إجماعهم على الحكم العام مع سبق المخصص خطأ والإجماع على الخطأ لا يجوز
المسألة الخامسة
في أن تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول صلى الله عليه و سلم هل هو جائز أم لاوالتحقيق فيه أن اللفظ العام إما أن يكون متناولا للرسول صلى الله عليه و سلم أولا يكون متناولا له
فإن كان متناولا له كان ذلك الفعل مخصصا لذلك العموم في حقه وهل يكون مخصصا للعموم في حق غيره فنقول
إن دل دليل على أن حكم غيره كحكمه في الكل مطلقا أو في الكل إلا ما خصه الدليل أو في تلك الواقعة كان ذلك تخصيصا في حق غيره ولكن المخصص للعموم لا يكون ذلك الفعل وحده بل الفعل مع ذلك الدليل وإن لم يكن كذلك لم يجز تخصيص ذلك العام في حق غيره
وأما إن كان اللفظ العام غير متناول للرسول عليه السلام بل للأمة فقط فإن قام الدليل على أن حكم الأمة مثل حكم النبي صلى الله عليه و سلم صار العام مخصوصا بمجموع فعل الرسول عليه السلام مع ذلك الدليل وإلا فلا
واحتج من منع هذا التخصيص مطلقا بأن المخصص للعام هو الدليل الذي دل على
وجوب متابعته وهو قوله تعالى فاتبعوه وذلك اعم من العام الذي يدل على بعض الأشياء فقط فالتخصيص بالفعل يكون تقديما للعام علىالخاص وهو غير جائز والجواب
أن المخصص ليس مجرد قوله تعالى فاتبعوه بل هو مع ذلك الفعل ومجموعهما أخص من العام الذي ندعي تخصيصه بالفعل
المسألة السادسة
من فعل ما يخالف مقتضى العموم بحضرة الرسول صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليه فعدم الإنكار من الرسول صلى الله عليه و سلم قاطع في تخصيص العام في حق ذلك الفاعلأما في حق غيره فإن ثبت أن حكمه صلى الله عليه و سلم في الواحد حكمه في الكل كان ذلك التقرير تخصيصا في حق الكل وإلا فلا والله أعلم
الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون وفيه مسائل
المسألة الأولى
يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عندنا وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله وقال قوم لايجوز أصلاوقال عيسى بن أبان إن كان قد خص قبل ذلك بدليل مقطوع به جاز وإلا فلا
وقال الكرخي إن كان قد خص بدليل منفصل صار مجازا فيجوز ذلك وإن خص بدليل متصل أو لم يخص أصلا لم يجز
وأما القاضي أبو بكر رحمه الله إنه اختار التوقف
لنا
أن العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان وخبر الواحد أخص من العموم فوجب تقديمه على العمومإنما قلنا إنهما دليلان لأن العموم دليل بالاتفاق
وأما خبر الواحد فهو ايضا دليل لأن العمل به يتضمن دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا فكان دليلا
وإذا ثبت ذلك وجب تقديمه على العموم لأن تقديم العموم عليه يفضي إلى إلغائه بالكلية أما تقديمه على العموم فلا يفضي إلى إلغاء العموم بالكلية فكان ذلك أولى كما في سائر المخصصات
وأما جمهور الآصحاب فقالوا أجمعت الصحابة على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبينوه بخمس صور
إحداها
أنهم خصصوا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بما رواه الصديق رضي الله عنه أنه عليه الصلاة و السلام قال نحن معاشر الأنبياء لا نورثوثانيها
خصصوا عموم قوله تعالى فإن كن نساءفوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك بخبرمحمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه و سلم جعل للجدة السدس لأن المتوفاة إذا خلفت زوجا وبنتين وجدة فللزوج الربع ثلاثة وللبنين الثلثان ثمانية وللجدة السدس اثنان عالت المسألة إلى ثلاثة عشر
وثمانية من ثلاثة عشر أقل من ثلثي التركة
وثالثها
أنهم خصصوا قوله تعالى وأحل الله البيع بخبر أبي سعيد في المنع من بيع الدرهم بالدرهمينورابعها
خصصوا قوله تعالى اقتلوا المشركين بخبر عبدالرحمن بن عوف في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب
وخامسها
خصصوا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بخبر أبي هريرة في المنع من نكاح المرأة على عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها ولقائل أن يقول هل أجمعت الصحابة على تخصيص هذه العمومات في هذه الصور أو ما أجمعت
فإن قلتم ما أجمعوا فقد سقط دليلكم وإن قلتم أجمعوا فلم لا يجوز أن يقال المخصص لهذه العمومات ذلك الإجماع
فإن قلت لا بد لذلك الإجماع من مستند هو هذه الأخبار إذ رب إجماع خفي مستنده لاستغنائهم بالإجماع عنه
سلمنا أن ذلك المستند هو هذه الأخبار لكن لعل هذه الأخبار كانت متواترة عندهم ثم صارت آحادا عندنا
واحتج المانعون بالإجماع والخبر والمعقول
أما الإجماع فهو أن عمر رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس وقال لا ندع
كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو كذبتوأما الخبر فما روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه والخبر الذي يخصص الكتاب على مخالفة الكتاب فوجب رده
وأما المعقول فوجهان
الأول
أن الكتاب مقطوع به وخبر الواحد مظنون والمقطوع أولى من المظنونوالثاني
ان النسخ تخصيص في الأزمان والتخصيص تخصيص في الأعيان فنقول لو جاز التخصيص بخبر الواحد في الأعيان لكان لأجل أن تخصيص العام أولى من إلغاء الخاص وهذا المعنى قائم في النسخ فكان يلزم جواز النسخ بخبر الواحد ولما لم يجز ذلك علمنا أن ذلك أيضا غير جائزوالجواب عن الأول
أنا لا ندعي تخصيص العموم بكل ما جاء من أخبار الآحادحتى يكون ذلك علينا وإنما نجوزه بالخبر الذي لا يكون راويه متهما بالكذب والنسيان وهذا الشرط ما كان حاصلا هنا لأن عمر رضي الله عنه قدح في روايتها بذلك فلم يكن قادحا في غرضنا بل هو بأن يكون حجة لنا أولى وذلك لأن عمر رضي الله عنه بين أن روايتها إنما صارت مردودة لكون الراوي غير مأمون من الكذب والنسيان ولو كان خبر الواحد المقتضي لتخصيص الكتاب مردودا كيف ما كان لما كان لذلك التعليل وجه
وعن الثاني
أن ما ذكرتموه يقتضي أن لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة فإن قلتم إن ما يقتضي تخصيص الكتاب لا يكون على خلافهقلنا في مسألتنا ذلك بعينه
وعن الثالث
أن البراءة الأصلية يقينية ثم إنا نتركها بخبر الواحد فبطل قولكم إن المقطوع لا يترك بالمظنونثم نقول لا نسلم حصول التفاوت وبيانه من وجهين
الأول
أن الكتاب مقطوع في متنه مظنون في دلالته والخبر مظنون في دلالته فلم قلتم إنه حصل التفاوت بينهما على هذا التقديرالثاني
أن الدليل القاطع لما دل على وجوب العمل بالخبر المظنون لم يكن وجوب العمل مظنونا لأن تقدير ذلك أن الله تعالى قال مهما حصل في قلبكم ظن صدق الراوي فاقطعوا أن حكمي ذلكفإذا وجدنا ذلك الظن واستدللنا به على الحكم كنا قاطعين بالحكم وإذا كان كذلك فلم قلتم إن التفاوت حاصل على هذا التقدير
وعن الرابع
أن الأصوليين اعتمدوا في الجواب على حرف واحد وهو أن العقل ليس يأبى ذلك وإنما فصلنا بينهما لإجماع الصحابةعلى الفصل بينهما فقبلوا خبر الواحد في التخصيص وردوه في النسخوهذا الجواب ضعيف
لأنا بينا أن الذي عولوا عليه في أنهم قبلوا خبر الواحد في التخصيص ضعيفوإذا ثبت ذلك فنقول ثبت بما ذكرنا أن القياس يقتضي أنه لو قبل خبر الواحد في التخصيص لوجب قبوله في النسخ وثبت بالاتفاق أنهم ما قبلوه في النسخ فوجب أن يقال إنهم ما قبلوه في التخصيص أيضا ضروة العمل بالدليل
والجواب الصحيح لا يحصل إلا بذكر الفرق بينهما
وهو أن التخصيص أهون من النسخ ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف تأثيره في الآقوى والله أعلم
تنبيه
فأما قول عيسى بن أبان والكرخي فمبنيان علىحرف واحد وهو أن العام المخصوص عند عيسى مجاز والعام المخصوص بالدليل المنفصل مجاز عند الكرخي وإذا صار مجازا صارت دلالته مظنونة ومتنه مقطوعا وخبر الواحد متنه مظنون ودلالته مقطوعة فيحصل التعادلفأما قبل ذلك فإنه حقيقة في العموم فيكون قاطعا في متنه وفي دلالته فلا يجوز أن يرجح عليه المظنون
فهذا هو مأخذهم والكلام عليه هو ما تقدم والله أعلم
المسألة الثانية
يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي الحسين البصري والأشعري وأبي هاشم أخيراومنهم من منع منه مطلقا وهو قول الجبائي وأبي هاشم أولا ومنهم من فصل ثم ذكروا فيه وجوها أربعة
الأول
قول عيسى بن أبان أن تطرق التخصيص إلى العموم جاز وإلا فلاوالثاني
قول الكرخي وهو أنه إن خص بدليل منفصل جاز وإلا فلا
والثالث
قول كثير من فقهائنا ومنهم ابن سريج يجوز بالقياس الجلي دون الخفيثم اختلفوا في تفسير الجلي والخفي على ثلاثة أوجه
أحدها
أن الجلي هو قياس المعنى والخفي هو قياس الشبهوثانيها
أن الجلي هو مثل قوله صلى الله عليه و سلم لا يقضي القاضي وهو غضبان وتعليل ذلك بما يدهش العقلعن إتمام الفكر حتى يتعدى إلى الجائع والحاقن
وثالثها
قول أبي سعيد الاصطخري وهو أن الجلي هو الذي إذا قضى القاضي بخلافة ينتقض قضاؤهوالرابع
قول الغزالي رحمه الله وهو أن العام والقياس إن تفاوتا في إفادة الظن رجحنا الأقوى وإن تعادلا توقفنا
وأما القاضي أبو بكر وأمام الحرمين فقد ذهبا إلى الوقف
قال إمام الحرمين والقول بالوقف يشارك القول بالتخصيص من وجه ويباينه من وجه
أما المشاركة فلأن المطلوب من تخصيص العام بالقياس إسقاط الاحتجاج بالعام والوقف يشاركه فيه
وأما المباينة فهي أن القائل بالتخصيص يحكم بمقتضى القياس والواقف لا يحكم به
تنبيه
نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر إلى عموم الخبر المتواتر وكنسبة قياس خبر الواحد إلى عموم خبر الواحد والخلاف جار في الكل وكذا القول في قياس الخبر المتواتر بالنسبة إلى عموم الكتاب وبالعكس
أما قياس خبر الواحد إذا عارضه عموم الكتاب أو السنة المتواترة وجب أن يكون تجويزه أبعد
لنا
أن العموم والقياس دليلان متعارضان والقياس خاص فوجب تقديمهأما ان العموم دليل فبالاتفاق
وأما أن القياس دليل فلأن العمل به دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا وسيأتي تقرير هذه الدلالة في باب القياس إن شاء الله تعالى
وإذا ثبت ذلك فالتقرير ما تقدم في المسألة الأولى
واحتج المانعون بأمور
أحدها
أن الحكم المدلول عليه بالعموم معلوم والحكم المدلول عليه بالقياس مظنون والمعلوم راجح على المظنونوثانيها
أن القياس فرع النص فلو خصصنا العموم بالقياس لقدمنا الفرع على الأصل وإنه غير جائزوثالثها
أن حديث معاذ دل على أنه لا يجوز الاجتهاد إلا بعد فقد ذلك الحكم في الكتاب والسنة وذلك يمنع من تخصيص النص بالقياس
ورابعها
أن الأمة مجمعة على أن من شرط القياس أن لا يرده النص وإذا كان العموم مخالفا له فقد ردهوخامسها
أنه لو جاز التخصيص بالقياس لجاز النسخ به وقد تقدم تقريرهوالجواب عن الأول ما تقدم
وعن الثانيأن القياس المخصص للنص يكون فرعا لنص آخر وحينئذ يزول السؤال
فإن قلت لما كان القياس فرعا لنص آخر فك مقدمة لا بد منها في دلالة النص على الحكم كانت معتبرة في الجانبين
وأما المقدمات التي لا بد منها في دلالة القياس فهي مختصة بجانب القياس فقط
فإذن إثبات الحكم بالقياس يتوقف على مقدما أكثر وبالعموم على مقدمات أقل فكان إثبات الحكم بالعموم أظهر من إثباته بالقياس والأقوى لا يصير مرجوحا بالأضعف
قلت قد تكون دلالة بعض العمومات على مدلوله أقوى وأقل مقدمات من دلالة عموم آخر على مدلوله
وعند هذا يظهر الحق ما قاله الغزالي رحمه الله وهو أن دلالة العموم المخصوص على مدلوله إذا افتقرت إلى مقدمات كثيرة ودلالة العموم الذي هو أصل القياس إذا افتقرت إلى مقدمات قليلة بحيث تكون تلك المقدمات المعتبرة في القياس معادلة لمقدمات قليلة بحيث تكون تلك المقدمات مع
المقدمات المعتبرة في القياس معادلة لمقدمات العموم المخصوص أو أقل جاز وحينئذ لا يتوجه ما قالوه
وعن الثالث
أن حديث معاذ إن اقتضى أنه لا يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس فليقتض أن لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ولا شك في فساذ ذلكوعن الرابع
أن نقول مالذي تريد بقولك شرط القياس أن لا يدفعه النصإن أردتم أن شرطه أن لا يكون رافعا لكل ما اقتضاه النص فحق
وإن أردتم أن لا يكون رافعا لشيء مما اقتضاه النص فهو عين المتنازع
وعن الخامس ما تقدم في المسألة الأولى
المسألة الثالثة
إذا قلنا المفهوم حجة فلا شك أن دلالته أضعف من دلالة المنطوق فهل يجوز تخصيص العام بهمثاله إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم ثم قال الشارع في سائمة الغنم زكاة فهذا مفهومه يقتضي تخصيص ذلك العام
ولقائل أن يقول إنما رجحنا الخاص على العام لأن دلالة الخاص على ما تحته أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص والأقوى راجح
وأما ها هنا فلا نسلم أن دلالة المفهوم على مدلوله أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص بل الظاهر أنه أضعف وإذا كان كذلك كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحا للأضعف على الأقوى وانه لا يجوز والله أعلم
القول في بناء العام على الخاص
إذا روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خبران خاص وعام وهما كالمتنافيين فإما أن نعلم تاريخهما أو لانعلمفإن علمنا التاريخ فإما أن نعلم مقارنتهما أو نعلم تراخي أحدهما عن الآخر
فإن علمنا مقارنتهما نحو أن يقول في الخيل زكاة ويقول عقيبه ليس في الذكور من الخيل زكاة فالواجب أن يكون الخاص مخصصا للعام
ومنهم من قال بل ذلك القدر من العام يصير معارضا للخاص
لنا وجوه
الأولأن الخاص أقوى دلالة على ما يتناوله من العام والأقوى راجح فالخاص راجح
بيان الأول أن العام يجوز إطلاقه من غير أرادة ذلك الخاص أما ذلك الخاص فلا يجوز إطلاقه من غير إرادة ذلك الخاص فثبت أنه أقوى
الثاني
أن السيد إذا قال لعبده اشتر كل ما في السوق من اللحم ثم قال عقيبه لا تشتر لحم البقر فهم منه إخراج لحم البقر من كلامه الأولالثالث
إن إجراء العام على عمومه إلغاء للخاص واعتبار الخاص لا يوجب إلغاء واحد منهما فكان ذلك أولى
فإن قلت هلا حملتم قوله في الخيل زكاة على التطوع وقوله لا زكاة في الذكور من الخيل على نفي الوجوب وهذا وإن كان مجازا لكن التخصيص أيضا مجاز فلم كان مجازكم أولى من مجازنا
قلت إنا نفرض الكلام فيما إذا قال أوجبت الزكاة في الخيل ثم قال لا أوجبها في الذكور من الخيل
ولأن قوله في الخيل زكاة يقتضي وجوبها في الإناث والذكور فلو حملناه على التطوع لكنا قد عدلنا باللفظ عن ظاهره في الإناث لدليل لا يتناول الإناث وليس كذلك إذا أخرجنا الذكور في قوله في الخيل زكاة لأنا نكون قد أخرجنا من العام شيئا لدليل يتناوله واقتضى إخراجه
أما إذا علمنا تأخير الخاص عن العام فإن ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام كان ذلك بيانا للتخصيص
ويجوز ذلك عند من يجوز تأخير بيان العام ولا يجوز عند المانعين منه
وإن ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان ذلك نسخا وبيانا لمراد المتكلم فيما بعد دون ما قبل لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة
أما إن كان العام متأخرا عن الخاص فعند الشافعي وأبي الحسين البصري أن العام يبتى على الخاص وهو المختار
وعند أبي حنيفة والقاضي عبدالجبار بن احمد أن العام
المتأخر ينسخ الخاص المتقدم وتوقف ابن القاص فيه
لنا وجوه
الأولالخاص أقوى دلالة على ما يتناوله من العام والأقوى راجح فالخاص راجح
الثاني
إن إجراء العام على عمومه يوجب إلغاء الخاص واعتبار الخاص لا يوجب إلغاء واحد منهما فكان أولى
وأحتج أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله بأمور
أحدها
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنا نأخذ بالأحدث فالأحدثفإذا كان العام متأخرا كان أحدث فوجب الأخذ به
وثانيها
لفظان تعارضا وعلم التاريخ بينهما فوجب تسليط الأخير على السابق كما لوكان الأخير خاصا
واحترزنا بقولنا لفظان عن العام الذي يخصه العقل فإنا هناك سلطنا المتقدم
وثالثها
أن اللفظ العام في تناوله لآحاد ما دخل تحته يجري مجرى ألفاظ خاصة كل واحد منها يتناول واحدا فقط من تلك الآحاد لأن قوله تعالى اقتلوا المشركين قائم مقام قوله اقتلوا زيدا المشرك اقتلوا عمرا أقتلوا خالدا ولو قال ذلك بعد ما قال لا تقتلوا زيدا كان الثاني ناسخاواحتج ابن القاص على التوقف
بأن هذين الخطابين كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر لأنه إذا قال لا تقلوا اليهود ثم قال بعده اقتلوا المشركين فقوله لا تقتلوا اليهود أخص من قوله اقتلوا المشركين من حيث إن اليهودي أخص من المشرك وأعم منه من حيث إنه دخل في المتقدم من الأوقات مالم يدخل في المتأخر وهو ما بين زمان ورود المتقدم والمتأخر
فظهر أن الخاص المتقدم أعم في الأزمان وأخص في الأعيان والعام المتأخر بالعكس فكل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر وإذا ثبت ذلك وجب التوقف والرجوع إلى الترجيح كما في كل خطابين هذا شأنهما
والجواب عن الأول
أن هذا قول الصحابي فيكون ضعيف الدلالةفنخصه بما إذا كان الأحدث هو الخاص
وعن الثاني
أن الفرق ما ذكرنا من أن الخاص أقوى من العام فوجب تقديمه عليه ولأنا لو لم نسلط الخاص المتأخر على العام المتقدم لزم إلغاء الخاصأما لو لم نسلط العام المتأخر على الخاص المتقدم فلا يلزم ذلك فظهر الفرق
وعن الثالث
أنه إذا كان اللفظ عاما احتمل التخصيص وليس كذلك إذا كان خاصا ولهذا لو كان قوله لا تقتلوا اليهود مقارنا لقوله اقتلوا المشركين لخصهولو قارن المفصل لناقضه ولم يخصه لأن الخاص لا يحتمل التخصيص
وأما الذي تمسك به ابن القاص فهو ضعيف لأنه فرض الخاص المتقدم نهيا فلا جرم عم الأزمان وفرض العام المتأخر أمرا فلا جرم لم يعم الآزمان فصح له ما ادعاه من كون الخاص أعم من العام من هذا الوجه أما لو فرضنا الخاص المتقدم أمرا والعام المتأخر نهيا فإنه لا يستقيم كلامه لأن الخاص المتقدم لا شك أنه خاص في الأعيان وهو أيضا خاص في الأزمان لأن الأمر لا يفيد التكرار أما العام المتأخر فإذا فرضناه نهيا كان أعم من المتقدم في الأعيان بالاتفاق وفي الأزمان أيضا لأن الأمر لا يتناول كل الأزمان بل يتناول زمانا واحدا
فها هنا المتأخر أعم من المتقدم من كل الوجوه فبطل ما قالوه والله أعلم
أما إذا لم يعرف التاريخ بينهما فعند الشافعي رضي الله عنه أن الخاص منهما يخص العام
وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يتوقف فيهما ويرجع إلى غيرهما أو إلى ما يرجح
أحدهما
على الآخروهذا سديد على أصله لأن الخاص دائر بين أن يكون منسوخا وبين أن يكون مخصصا وناسخا مقبولا وناسخا مردودا وعند حصول التردد يجب التوقف
واعتمد أصحابنا فيه على وجهين
أحدهما
أنه ليس للخاص مع العام إلا أن يقارنه أو يتقدمه أو يتأخر عنه
وقد ثبت تخصيص العام بالخاص عندنا على التقديرات الثلاثة فعند الجهل بالتاريخ يكون الحكم أيضا كذلك
وهذا ضعيف لأن الخاص المتأخر عن العام إن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام كان تخصيصا
وإن ورد بعده كان نسخا
وعلى هذا نقول إن كان العام والخاص مقطوعين أو مظنونين أو العام مظنونا والخاص مقطوعا وجب ترجح الخاص على العام لأن الخاص دائر بين أن يكون ناسخا أو مخصصا
وعلى التقدير ين فالخاص مقدم في هذه الصورة
أما إذا كان العام مقطوعا به والخاص مظنونا فبتقدير أن يكون الخاص مخصصا وجب العمل به لأن تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز
لكن بتقدير أن يكون ناسخا لم يجب العمل به لأن نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز
فالحاصل أن الخاص دائر بين أن يكون مخصصا وبين أن يكون ناسخا مقبولا وبين أن يكون ناسخا مردودا
وإذا كان كذلك لم يجب تقديم الخاص على العام مطلقا
الثاني
أن العموم بالقياس مطلقا فلأن يخص بخبر الواحد أولىوهو ضعيف لأن القياس يقتضي أصلا يقاس عليه فذلك الأصل إن كان متقدما على العام لم يجز القياس عليه عندنا وكذا القول إذا لم يعرف تقدمه وتأخره لا يجوز القياس عليه
والمعتمد أن فقهاء الأمصار في هذه الأعصار يخصصون أعم الخبرين بأخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ
فإن قلت إن ابن عمر رضي الله عنهما لم يخص قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم بقوله صلى الله عليه و سلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان
وعنه أيضا لما سئل عن نكاح النصرانية حرمه محتجا بقوله تعالى ولا تنكحوا
المشركات حتى يؤمن وجعل هذا العام رافعا لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب مع خصوصه
قلت ادعينا إجماع أهل هذه الأعصار ويحتمل أن يكون ابن عمر امتنع من ذلك الدليل
تنبيه
إن الحنفية لما اعتقدوا أن الواجب في مثل هذا العام والخاصإما التوقف وإما الترجيح ذكر عيسى بن أبان ثلاثة أوجه في الترجيح
أحدها
اتفاق الآمة على العمل بأحدهاوثانيها
عمل أكثر الأمة بأحد الخبرين وعيبهم على من لم يعمل بهكعملهم بخبر أبي سعيد وعيبهم علي ابن عباس حين نفى الربا في النقدين
وثالثها
أن تكون الرواية لأحدهما أشهروزاد أبو عبدالله البصري وجهين آخرين
أحدهما
أن يتضمن أحد الخبرين حكما شرعياوثانيهما
أن يكون أحد الخبرين بيانا للآخر بالاتفاق كاتفاقهم على أن قوله صلى الله عليه و سلم لاقطع إلا في ثمن المجن بيان لآية السرقة قال أبو الحسين البصري رحمه الله هذه الأمور أمارة لتأخر أحد الخبرين لأن الخبر لو كان متقدما منسوخا لما اتفقت الأمة على استعماله ولا عابوا من ترك استعماله ولما كان نقله أشهر ولما أجمعوا على كونه بيانا لناسخه
وكون الحكم غير شرعي يقتضي كون الخبر الذي تضمنه مصاحبا للعقل وأن الخبر المتضمن للحكم الشرعي متأخر
وهذاالوجه ضعيف والله أعلم
القول فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك وفيه مسائل
المسألة الأولى
الخطاب الذي يرد جوابا عن سؤال سائل إما أن لا يكون مستقلا بنفسه أو يكونوالأول على قسمين
لأن عدم استقلاله إما أن يكون لأمر يرجع إليه كقوله صلى الله عليه و سلم وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص أذا جف قالوا نعم قال فلا إذنوإما أن يكون لأمر يرجع إلى العادة كقوله والله لا آكل في جواب من يقول كل عندي لأن هذا الجواب مستقل بنفسه غير أن العرف اقتضى عدم استقلاله حتى صار مفتقرا إلى السبب الذي خرج عليه
والقسم الثاني على ثلاثة أنواع لآن الجواب إما أن يكون أخص أو مساويا أو
أعموالأعم إما ان يكون أعم مما سئل عنه كقوله
ص -
لما سئل عن بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء
أو يكون أعم في غير ما سئل عنه كقوله صلى الله عليه و سلم وقد سئل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته
إذا عرفت هذه الأقسام فنقول
أما الجواب الذي لا يستقل بنفسه فإنه يفيد مع سببه فيكون السبب موجودا في
كلام المجيب تقديرا وإلا لم يفدولو أن المتكلم أتى بالسبب في كلامه فقال والله لا آكل عندك لكان اليمين مقصورا على الأكل عنده
وأما الجواب المستقل المساوي فلا إشكال فيه
وأما الأخص فهو جائز بثلاث شرائطأحدها
أن يكون فيما خرج عن الجواب تنبيه على ما لم يخرج منهوثانيها
أن يكون السائل من أهل الاجتهادوثالثها
أن لا تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد وبدون هذه الشرائط لا يجوزوأما إذا كان الجواب أعم في غير ماسئل عنه فلا شبهة في أنه يجري على عمومه
أما إذا كان الجواب أعم مما سئل عنه فالحق أن العبرة
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب خلافا للمزني وأبو ثور فإنهما زعما أن خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ قال إمام الحرمين وهو الذي صح عن الشافعي رضي الله عنه
لنا وجهان
الأولأن المقتضى للعموم قائم وهو اللفظ الموضوع للعموم والمعارض الموجود وهو خصوص السبب لا يصلح معارضا لأنه لا منافاة بين عموم اللفظ وخصوص السبب فإن الشارع لو صرح وقال يجب عليكم أن تحملوا اللفظ العام على عمومه عمومه وأن لا تخصصوه بخصوص سببه كان ذلك جائزا والعلم بجوازه ضروري
الثاني
أن الأمة مجمعة على أن آية اللعان والظهار والسرقة وغيرها إنما نزلت في أقوام معينينمع أن الأمة عمموا حكمها ولم يقل أحد أن ذلك التعميم خلاف الأصل
واحتج المخالف
بأن المراد من ذلك الخطاب إما بيان ما وقع السؤال عنه أو غيرهفإن كان الأول وجب أن لا يزاد عليه وذلك يقتضي أن يتخصص بتخصص السبب
وإن كان الثاني وجب أن لا يتأخر ذلك البيان عن تلك الواقعة
والجواب
أن ما ذكروه يقتضي أن يكون ذلك الحكم مقصورا على ذلك السائل وفي ذلك الزمان والمكان والهيئةوأيضا فلم لا يجوز أن يكون ذلك السؤال الخاص اقتضى ذلك البيان
العام لا بد على امتناعه من دليل والله أعلم
تنبيه
هذا العام وإن كان حجة في موضع السؤال وفي غيره إلا أن دلالته على موضع السؤال أقوى منها على غير ذلك الموضعوهذا يصلح أن يكون من المرجحات والله أعلم
المسألة الثانية
الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي وهو قول الشافعي رضي الله عنه لأنه قال إن كان الراوي حمل الخبر على أحد محمليه صرت إلى قوله وإن ترك الظاهر لم أصر إلى قوله خلافا لعيسى بن أبان ومثاله خبر أبي هريرة في أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب سبعا فإنه خص ذلك بمذهب أبي هريرة في أنه يغسل ثلاثا
ومنهم من فصل فقال إن وجد خبر يقتضي تخصيصه أو وجد في الأصول ما يقتضي ذلك لم يخص الخبر بمذهبه وإلا خص بمذهبه
لنا
أن مخالفة الراوي تحتمل أقساما ثلاثة طرفين وواسطة أما طرف الإفراط فهو أن يقال الراوي عالم بالضرورة أنه صلى الله عليه و سلم أراد بذلك العام الخاص إما لخبر آخر قاطع يقتضي ذلك أو لشيء من قرائن الأحوال
وهذا الاحتمال يعارضه أنه لو كان كذلك لوجب على الراوي أن يبين ذلك إزالة للتهمة عن نفسه وللشبهة
وأما طرف التفريط فهو أن يقال إنه ترك العموم بمجرد الهوى وهو معارض بما
أن الظاهر من عدالته خلافه وأما الوسط فهو أنه خالفه بدليل ظنه أقوى منه إما محتكل أو قياسوذلك الظن يحتمل أن يكون خطأ ويحتمل أن يكون صوابا وإذا تعارضت الاحتمالات في مخالفة الراوي وجب تساقطها والرجوع إلى العموم
واحتج المخالف
بأن مخالفة الراوي إن كانت لا عن طريق كان ذلك قادحا في عدالته فالقدح في عدالته قدح في متن الخبروإن كانت عن طريق فذلك الطريق إما محتمل أو قاطع ولو كان الدليل محمتلا لذكره إزالة للتهمة عن نفسه والشبهة عن غيره ولما بطل ذلك تعين القطع
والجواب
أن إظهاره لذلك الدليل المحتمل إنما يجب عليه مع من ناظره فلعله لم تتفق تلك المناظرةسلمنا أنه ذكره لكن لعله لم ينقل أو نقل لكنه لم يشتهر والله أعلم
المسألة الثالثة
الحق أنه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لأبي ثورمثاله قوله صلى الله عليه و سلم أيما إهاب دبغ فقد طهر قال المراد جلد الشاة لأنه قال صلىالله عليه
وسلم في جلد شاة ميمونة دباغها طهورها
لنا
أن المخصص للعام لا بد وأن يكون بينه وبين العام منافاة ولا منافاة بين كل الشيء وبعضه لأن الكل محتاج إلى البعض والمحتاج إليه لا ينافي المحتاجاحتج المخالف
بأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه فتخصيص الخاص بالذكر يدل على نفي الحكم عن غيره وذلك يقتضي تخصيص العام
والجواب
أنا لا نقول بدليل الخطاب سلمناه لكن التمسك بظاهر العموم أولى من التمسك بالمفهوم على ما تقدمالمسألة الرابعة
اختلفوا في التخصيص بالعاداتوالحق أن نقول العادات إما أن يعلم من حالها أنها كانت حاصلة في زمان الرسول صلى الله عليه و سلم وأنه صلى الله عليه و سلم ما كان يمنعهم منها
أو يعلم أنها ما كانت حاصلة
أو لا يعلم واحد من هذين الأمرين
فإن كان الأول صح التخصيص بها لكن المخصص في الحقيقة هو تقرير الرسول صلى الله عليه و سلم عليها
وإن كان الثاني لم يجز التخصيص بها لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع بل لو أجمعوا عليه لصح التخصيص بها لكن المخصص حينئذ هو الإجماع لا العادة
وإن كان الثالث كان محمتلا للقسمين الأولين ومع احتمال كونه غير مخصص لا يجوز القطع بذلك والله أعلم
المسألة الخامسة
كونه مخاطبا هل يقتضي خروجه عن الخطاب العامأما في الخبر فلا لقوله تعالى وهو بكل شيء عليم لأن اللفظ عام ولا مانع من الدخول
وأمافي الأمر الذي جعل جزاء كقوله من دخل داري فأكرمه فيشبه أن يكون كونه أمرا قرينة مخصصة والله أعلم
المسألة السادسة
الخطاب المتناول لما يندرج فيه النبي صلى الله عليه و سلم والأمة كقوله يا أيها الناس ياأيها الذين آمنوا عام في حقهما
ومنهم من خصصه بالأمة قال لأن منصب الرسول صلى الله عليه و سلم يقتضي إفراده بالذكر وهو باطل لأن اللفظ عام ولا مانع من دخول الرسول صلى الله عليه و سلم فيه
وقال الصيرفي كل خطاب لم يصدر بأمر الرسول عليه الصلاة و السلام بتبليغه ولكن ورد مطلقا فالرسول صلى الله عليه و سلم مخاطب به كغيره
وكل ما كان مصدرا بأمر الرسول بتبليغه فذلك لا يتناوله كقوله قل يا
أيها الناس
المسألة السابعة
الخطاب المتناول لما يندرج فيه الحر والعبد والمسلم والكافر لا يخرج عنه العبد والكافرأما العبد فلأن اللفظ عام وقيام المانع الذي يوجب التخصيص خلاف الأصل
وهذا القدر يوجب دخول العبد فيه بل العبادة التي تترتب على المالكية لا تتحقق في حق العبد لأن العبد ليس له صلاحية المالكية فأما فيما عداه فهو داخل فيه
فإن قلت المانع من ذلك هو ما ثبت من وجوب خدمته لسيده في كل وقت يستخدمه فيه وذلك يمنعه من العبادات في هذه الأوقات
فإن قلتم إنما يلزمه خدمة سيده لو فرغ من العبادات فنقول لم كان تخصيص الدليل الدال على وجوب خدمة
السيد بما دل على وجوب العبادة أولى من تخصيص ما دل على وجوب العبادة بما دل على وجوب خدمة السيد
قلت ما دل على وجوب خدمة السيد في حكم العام وما دل على وجوب العبادات في حكم الخاص لأن كل عبادة يتناولها لفظ مخصوص كآية الصلاة وآية الصيام والخاص متقدم على العام
وأما بيان أن كونه كافرا لا يخرجه عن العموم فقد ثبت في باب أن الكفار مخاطبون بالشرائع والله أعلم
السمألة الثامنة
قصد المتكلم بخطابه إلى المدح أو إلى الذم لا يوجب تخصيص العامومنع بعض فقهائنا من عموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة وأبطلوا التعلق به في ثبوت الزكاة في الحلي وقالوا
القصد به إلحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة وليس القصد به العموم
والجواب
أنا فهمنا الذم من الآية لدلالة اللفظ عليه واللفظ دل علىالعموم فوجب إثباته وليست دلالتها على الذم مانعة من دلالتها على العموم
المسألة التاسعة
عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص العاممثاله أن اصحابنا لما احتجوا على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله صلى الله عليه و سلم لا يقتل مؤمن بكافر قالت الحنفية إنه صلى الله عليه و سلم عطف عليه قوله
ولا ذو عهد في عهده فيكون معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر
ثم إن الكافر الذي لا يقتل ذو العهد به هو الحربي فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه
والكلام عليه يقع في مقامين
الأول
أنا لا نسلم أن قوله صلى الله عليه و سلم ولا ذو عهد في عهده معناه ولا ذو عهد في عهده بكافربيانه أن قوله صلى الله عليه و سلم ولا ذو عهد في عهده كلام تام وإذا كان كذلك لم يجز إضمار تلك الزيادة
إنما قلنا أنه كلام تام لأنه قال ولا يقتل ذو عهد
لكان من الجائز أن يتوهم منه متوهم أن من وجد منه العهد ثم خرج عن عهده فإنه لا يجوز قتله فلما قال في عهده علمنا أن هذا النهي مختص بكونه في العهد
وإذا ثبت أن هذا القدر كلام تام لم يجز إضمار تلك الزيادة لأن الإضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة
سلمنا
أن قوله صلى الله عليه و سلم ولا ذو عهد في عهده معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر لكن لا نسلم أن هذا الكافر لما كان هو الحربي وجب أن يكون المراد بقوله لا يقتل مؤمن بكافر هو الحربي
بيانه
أن مقتضى العطف مطلق الاشتراك لا الاشتراك من كل الوجوه وإذا كان كذلك لم يجب ما قالوه والله أعلمالمسألة العاشرة
اختلفوا في أن العموم إذا تعقبه استثناء أو تقييد بصفة أو حكم وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما يتناوله هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أم لامثال الاستثناء قوله تعالى لا جناح عليكم إن
طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ثم قال عز و جل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون فاستثنى العفو وعلقه بكناية راجعة إلى النساء
ومعلوم أن العفو لايصح إلا من المالكات لأمورهن دون الصغيرة والمجنونة فهل يجب أن يقال الصغيرة والمجنونة غير مرادة بلفظ النساء في أول الكلام
مثال التقييد بالصفة قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني الرغبة في مراجعتهن
ومعلوم أن ذلك لا يتأتى في البائنة
ومثال التقييد بحكم آخر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك
وهذا أيضا لا يتأتى في البائن
إذا عرفت هذا فنقول
ذهب القاضي عبد الجبار إلى أنه لا يجب تخصيص ذلك العموم بتلك الأشياء
ومنهم من قطع بالتخصيص
ومنهم من توقف وهو المختار
والدليل عليه أن ظاهر العموم المتقدم يقتضي الاستغراق وظاهر الكناية يقتضي الرجوع إلى كل ما تقدم لأن الكناية يجب رجوعها إلى المذكور المتقدم والمذكور المتقدم في الآية الأولى وهو المطلقات لا بعضهن ألا ترى أن الإنسان إذا قال من دخل الدار من عبيدي ضربته إلا أن يتوبوا انصرف ذلك إلى جميع العبيد وجرى مجرى أن يقول إلا أن يتوب عبيدي الداخلون في الدار
وإذا ثبت ذلك فليست رعاية ظاهر العموم أولى من رعاية ظاهر الكناية فوجب التوقف والله أعلم
القسم الرابع من كتاب العموم والخصوص
في حمل المطلق على المقيد وفيه مسائل
المسألة الأولى
المطلق والمقيد إذا وردا فإما أن يكون حكم أحدهما مخالفا لحكم الآخر أو لا يكونوالأول
مثل أن يقول الشارع آتوا الزكاة وأعتقوا رقبة مؤمنة و لا نزاع في أنه لا يحمل المطلق على المقيد ها هنا لأنه لا تعلق بينهما أصلاوأما الثاني
فلا يخلو إما أن يكون السبب واحدا أو يكون هناك سببان متماثلان أو مختلفان وكل واحد من هذه الثلاثة فإما أن يكون الخطاب الوارد فيه أمرا أو نهيا فهذه أقسام ستة فلنتكلم فيها
أما إذا كان السبب واحدا وجب حمل المطلق على المقيد لأن المطلق جزء من
المقيد والآتي بالكل آت بالجزء لا محالة فالآتي بالمقيد يكون عاملا بالدليلين والآتي بغير ذلك المقيد لا يكون عاملا بالدليلين بل يكون تاركا لأحدهماوالعمل بالدليلين عند إمكان العمل بهما أولى من الإتيان بأحدهما وإهمال الآخر
فإن قيل لا نسلم أن المطلق جزءمن المقيد بيانه أن الإطلاق والتقييد ضدان والضدان لا يجتمعان
سلمنا ذلك لكن المطلق له عند عدم التقييد حكم وهو تمكن المكلف من الإتيان بأي فرد شاء من أفراد تلك الحقيقة والتقييد ينافي هذه المكنة فليس تقييد المطلق أولى من حمل المقيد على الندب وعليكم الترجيح
والجواب
أما أن المطلق جزء من المقيد فلأنا بينا أن المراد من المطلق نفس الحقيقة والمقيد عبارة عن الحقيقة مع قيد زائد ولا شك أن الإطلاق أحد أجزاء الحقيقة المقيدةقوله الإطلاق والتقييد ضدان
قلنا إن عنيت بالإطلاق كون اللفظ دالا على الحقيقة من حيث هي هي مع حذف جميع القيود السلبية والإيجابية فلا نسلم أن ذلك ينافي التقييد على ما بيناه
وإن عنيت بالإطلاق كون اللفظة دالة على الحقيقة الخالية عن جميع القيود فنحن لا نريد بالإطلاق ذلك بل الأول
وفرق بين الحقيقة بشرط لا وبين الحقيقة بلا شرط فإن عدم الشرط غير شرط العدم
وأيضا
فشرط الخلو عن جميع القيود غير معقول لأن هذا الخلو قيد قوله المطلق له بشرط عدم التقييد حكم وهو التمكن من الإتيان بأي فرد شاء من أفراد تلك الحقيقة
قلنا هذا الحكم غير مدلول عليه لفظا والتقييد مدلول عليه لفظا فهو أولى بالرعاية
وأما في جانب النهي فهو أن يقول لا تعتق رقبة ثم يقول لا تعتق رقبة كافرة والأمر فيه قريب مما مر
المسألة الثانية
اختلفوا في الحكمين المتماثلين إذا أطلق أحدهما وقيد الآخر وسببهما مختلفمثاله تقييد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان وإطلاقها في كفارة الظهار
وفيه ثلاثة مذاهب اثنان طرفان والثالث هو الوسط
أما الطرفان فأحدهما قول من يقول من أصحابنا تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظا
وثانيهما
قول كافة الحنفية إنه لا يجوز تقييد هذا المطلق بطريق ما البتةوثالثها
القول المعتدل وهو مذهب المحققين منا أنه يجوز تقييد المطلق بالقياس على ذلك المقيدولا ندعي وجوب هذا القياس بل ندعي أنه إن حصل القياس الصحيح ثبت التقييد وإلا فلا
واعلم أن صحة هذا القول إنما تثبت إذا أفسدنا القولين الأولين
أما الأول فضعيف جدا لأن الشارع لو قال أوجبت في كفارة القتل رقبة مؤمنة وأوجبت في كفارة الظهار رقبة كيف كانت لم يكن أحد الكلامين مناقضا للآخر فعلمنا أن تقييد أحدهما لا يقتضي تقييد الآخر لفظا
احتجوا
بأن القرآن كالكلمة الواحدة وبأن الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة وأطلقت في سائر الصور حملنا المطلق على المقيد فكذا ها هنا
والجواب عن الأول
أن القرآن كالكلمة الواحدة في أنه لا يتناقض لا في كل شيء وإلا وجب أن يتقيد كل عام ومطلق بكل خاص ومقيدوعن الثاني
أنا إنما قيدنا بالإجماعوأما القول الثاني فضعيف لأن دليل القياس وهو أن العمل به دفع للضرر المظنون عام في كل الصور
شبهة المخالف
أن قوله أعتق رقبة يقتضي تمكين المكلف من إعتاق أي رقبة شاء من رقاب الدنيا فلو دل القياس على أنه لا يجزيه إلا المؤمنة لكان القياس دليلا على زوال تلكالمكنة الثابتة بالنص فيكون القياس ناسخا وأنه خلاف الأصل
والجواب
هذا لا يتم على مذهبكم لأنكم اعتبرتم سلامة الرقبة عن كثير من العيوب فإن كان اشتراط الإيمان نسخا فكذا نفي تلك العيوب يكون نسخاوأيضا
فقوله أعتق رقبة لا يزيد في الدلالة على اللفظ العام وإذا جاز التخصيص العام بالقياس فلأن يجوز هذا التخصيص به أولى
تنبيه
إذا أطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين كيف يكون حكمهمثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله تعالى فعدة من أيام أخر وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وصوم كفارة الظهار الوارد مقيدا بالتتابع في قوله عز و جل فصيام شهرين متتابعين اختلفوا فيه على حسب ما مر في المسألة السلفة
فمن زعم أن المطلق يتقيد بالمقيد لفظا ترك المطلق ها هنا على إطلاقه لأنه ليس تقييده بأحدهما أولى من تقييده بالآخر
ومن حمل المطلق على المقيد لقياس حمله ها هنا على ما كان القياس عليه والله أعلم
النوع الرابع في المجمل والمبين
وفيه مقدمة وثلاثة أقسام
أما المقدمة
ففي تفسير الألفاظ المستعملة في هذا الباب وهي سبعةالأول
البيانوهو في أصل اللغة اسم مصدر مشتق من التبيين يقال بين يبين تبيينا وبيانا كما يقال كلم يكلم تكليما وكلاما واذن يؤذن تأذينا وأذانا
فالمبين يفرق بين الشيء وبين ما يشاكله فلهذا قيل
البيان عبارة عن الدلالة يقال بين فلان كذا بيانا حسنا إذا ذكر الدلالة عليه ويدخل فيه الدليل العقلي
وفي اصطلاح الفقهاء هو الذي دل على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد
والثاني
المبين وله معنيانأحدهما
ما احتاج الى البيان وقد ورد عليه بيانهوالثاني
الخطاب المبتدأ المستغني عن البيانالثالث
المفسر وله معنيانأحدهما
ما احتاج الى التفسير وقد ورد عليه تفسيره
وثانيهما
الكلام المبتدأ المستغني عن التفسير لوضوحه في نفسهالرابع
النص وهو كلام تظهر إفادته لمعناه ولا يتناول أكثر منه واحترزنا بقولنا كلام عن أمرينأحدهما
أن أدلة العقول والأفعال لا تسمى نصوصاوثانيهما
أن المجمل مع البيان لا يسمى نصا لأن قولنا نص عبارة عن خطاب واحد دون ما يقرن به ولأن البيان قد يكون غير القول والنص لا يكون الا قولاواحترزنا بقولنا تظهر إفادته لمعناه عن المجمل
فان قلت أليس قد يقال نص الله تعالى على وجوب الصلاة وإن كان قوله أقيموا الصلاة مجملا
قلت إنه ليس نصا إلا في إفادة الوجوب وهو فيها ليس بمجمل
واحترزنا بقولنا ولا يتناول أكثر منه عن قولهم اضرب عبيدي لأن الرجل إذا قال لغيره إضرب عبيدي لم يقل أحد إنه نص على ضرب زيد من عبيده لأنه لا يفيده
على التعيين ويقال إنه نص على ضرب جملة عبيده لأنه لا يفيد سواهم
الخامس
الظاهر وهو ما لا يفتقر في إفادته لمعناه الى غيره سواء أفاده وحده أو أفاده مع غيره وب هذا القيد الأخير يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص
وكنا قد قلنا في باب اللغات إن النص هو اللفظ الذي لا يمكن استعماله في غير معناه الواحد والظاهر هو الذي يحتمل غيره احتمالا مرجوحا ولا منافاة بين التعريفين
السادس
المجمل وهو في عرف الفقهاء ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعينهولا يلزم عليه قولك اضرب رجلا لأن هذا اللفظ أفاد ضرب رجل وهو ليس بمتعين في نفسه فأي رجل ضربته جاز وليس كذلك اسم القرء لأنه يفيد إما الطهر وحده وإما الحيض وحده واللفظ لا يعينه
وقول الله تعالى أقيموا الصلاة يفيد وجوب فعل متعين في نفسه غير متعين بحسب اللفظ
السابع
المؤول والتأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهروأما المحكم و المتشابه فقد مر تفسيرهما في باب اللغات والله أعلم
القسم الأول في المجمل وفيه مسائل
المسألة الأولى في أقسام المجملالدليل الشرعي إما أن يكون أصلا أو مستنبطا منه والأصل إما أن يكون لفظا أو فعلا
أما اللفظ فإما أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملا في موضوعه أو حال كونه مستعملا في بعض موضوعه أو حال كونه مستعملا لا في موضوعه ولا في بعض موضوعه
أما القسم الأول
فذاك هو أن يكون اللفظ محتملا لمعان كثيرة فلم يكن حمله على بعضها أولى من الباقي
ثم تناول اللفظ لتلك المعاني إما بحسب معنى واحد مشترك بين الكل وهو
المتواطىء كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده
أولا بحسب معنى واحد وهو المشترك كلفظ القرء
وأما القسم الثاني وهو أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملا في بعض
موضوعه فهو كالعام المخصوص بصفة مجملة أو استثناء مجمل أو بدليل منفصل مجهولمثال الصفة قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم فإنه تعالى لو اقتصر على ذلك لم يفتقر فيه
إلى بيان فلما قيده بقوله محصنين ولم ندر ما الإحصان لم نعرف ما أبيح لنا
ومثال الاستثناء قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الآنعام إلا ما يتلى عليكم
ومثال الدليل المنفصل المجهول كما إذا قال الرسول صلى الله عليه و سلم في قوله تعالى اقتلوا المشركين المراد بعضهم لا كلهم
وأما القسم الثالث وهو أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملا لا في
موضوعه ولا في بعض موضوعه فهو ضربانأحدهما الأسماء الشرعية
والآخر غيرها
مثالالأول كما إذا أمرنا الشرع بالصلاةونحن لا نعلم انتقال هذا الاسم إلى هذه
الأفعال احتجنا فيه إلى بيانوالثاني الأسماء التي دلت الأدلة على أنه لا يجوز حملها على حقائقها وليس بعض مجازاتها أولى من بعض بحسب اللفظ فلا بد من البيان
أما الفعل فإن مجرد وقوعه لا يدل على وجه وقوعه إلا أنه قد يقترن به ما يدل على الوجه الذي وقع عليه وحينئذ يستغنى عن البيان
وقد لا يقترن به ذلك فيكون مجملا
مثال
الأول إذا رأينا الرسول عليه الصلاة و السلام مواظبا على الإتيان بالسجودين علمنا أن ذلك من أفعال الصلاة
مثال
الثاني أن يقوم من الركعةالثانية ولا يجلس قدر التشهد جوزنا أن يكون قد
سها فيه وأن يكون قد تعمد ذلك ليدلنا على جواز ترك هذه الجلسةوأما المستنبط من الأصل فهو القياس ولا يتصور فيه الإجمال والله أعلم
المسألة الثانية
يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه و سلم والدليل عليه وقوعه في الآيات المتلوة
واحتج المنكر
بأن الكلام إما أن يذكر للإفهام أو لا للإفهاموالثاني
عبث غير جائز على الله تعالىوالأول
إما أن يكون قد قرن بالمجمل ما يبينه أو لم يفعل ذلك والأول تطويل من غير فائدة لأن التنصيص عليه أسهل وأدخل في الفصاحة من ذكره باللفظ المجمل ثم بيان ذلك المجمل بلفظ آخروأيضا فيجوز أن يصل الإنسان إلى ذلك المجمل قبل وصوله إلى ذلك البيان فيكون سببا للحيرة وإنه غير جائز
والثاني
باطل لأنه إذا أراد الإفهام مع أن اللفظ لا يدل عليه
وليس معه ما يدل عليه كان تكليفا بما لا يطاق وإنه غير جائز
والجواب
إن هذا الكلام ساقط عنا لأن عندنا يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريدوعند المعتزلة فلا يبعد أن يكون في ذكره باللفظ المجمل ثم إرداف ذلك المجمل بالبيان مصلحة لا يطلع عليها ومع الاحتمال لا يبقى القطع والله أعلم
القول في أمر ظن أنها من المجملات وليست كذلك وفيه مسائل
المسألة الأولىذهب الكرخي إلىأن التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم يقتضي الإجمال
وعندنا أنه يفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من تلك الذات فيفهم من قوله حرمت عليكم أمهاتكم تحريم الاستمتاع ومن قوله حرمت عليكم الميته تحريم
الأكل لأن هذه الأفعال هي الأفعال المطلوبة في هذه الأعيان
والحاصل أنا نسلم كونه مجازا في اللغة لكنه حقيقة في العرف
لنا وجوه
الأولأن الذي يسبق إلى الفهم من قول القائل هذا طعام حرام تحريم أكله ومن قوله هذه المرأة حرام تحريم وطئها ومبادرة الفهم دليل الحقيقة
وثانيها
ماروي أنه صلى الله عليه و سلم قال لعن الله اليهودحرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فدل هذا على أن تحريم الشحوم أفاد تحريم كل أنواع التصرف وإلا لم يتوجه الذم عليهم في البيع
وثالثها
أن المفهوم من قولنا فلان يملك الدار قدرته على التصرف فيها بالسكنى والبيع ومن قولنا فلان يملك الجاريةقدرته على التصرف فيها بالبيع والوطء والاستخدام وإذاجاز أن تتخلف فائدة الملك على هذا النحو جاز مثله في التحريم والتحليل
احتج الكرخي
بأن هذه الأعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة فكيف إذا كانت موجودة فإذن لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره بل المراد تحريم فعل من الأفعال المتعلقة بتلك الأعيان وذلك الفعل غير مذكور وليس إضمار بعضها أولى من بعض فإما أن نضمر الكل وهو محال لأنه إضمار من غير حاجة وهو غير جائز أو نتوقف في الكل وهو المطلوبوايضا
فالآية لو دلت على تحريم فعل معين لوجب أن يتعين ذلك الفعل في كل المواضع وليس كذلك لأن المراد بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم حرمة الاستمتاع وبقوله حرمت عليكم الميته حرمة الأكلوالجواب
لا نزاع في أنه لا يمكن إضافة التحريم إلى الأعيان لكن قوله ليس إضمار بعض الأحكام أولى من بعض ممنوع فإن العرف يقتضي إضافة ذلك التحريم إلى الفعل المطلوب منه والله أعلم
المسألة الثانية
ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم مجمل لأنه يحتمل مسح جميع الرأس ومسح بعضه وإذا ظهر الاحتمال يثبت الإجمال
وقال آخرون لو خلينا واللفظ لمسحنا جميع الرأس لأن الباء للإلصاق 3 وقال ابن جني لا فرق في اللغة بين أن تقول مسحت بالرأس وبين أن تقول مسحت الرأس لأن الرأس اسم للعضو بتمامه فوجب مسحه بتمامه
وقال بعض الشافعية إنها للتبعيض فهو يفيد مسح بعض الرأس
وقال آخرون لا إجمال فيه لأن لفظ المسح مستعمل في مسح الكل بالاتفاق وفي مسح البعض كما يقال مسحت
يدي بالمنديل ومسحت يدي برأس اليتيم وإن كان إنما مسحها ببعض الرأس والأصل عدم الاشتراك فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين مسح الكل ومسح البعض فقط وذلك هو مماسة جزء من اليد جزءا من الرأس
فثبت أن اللفظ ما دل إلا عليه فكان الآتي به عاملا باللفظ وحينئذ لا يتحقق الإجمال ويكفي في العمل به مسح أقل جزء من الرأس وهو قول الشافعي رضي الله عنه
المسألة الثالثة
اختلفوا في حرف النفي إذا دخل على الفعل كقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا عمل لمن لا نية لهفقال أبو عبدالله البصري إنه مجمل لأن ذات الصلاة والعمل موجودة فلا يمكن صرف النفي إليها فوجب صرفه إلى حكم
آخر وليس البعض أولى من البعض
فإما أن يحمل على الكل وهو إضمار من غير ضرورة ولأنه قد يفضي إلى التناقض لأنا لو حملناه على نفي الصحة ونفي الكمال معا وفي نفي الكمال ثبوت الصحة فيلزم التناقض
أولا يحمل على شيء من الأحكام بل يتوقف وهذا هو الإجمال
ومن الناس من فصل وقال هذا النفي إما أن يكون داخلا على مسمى شرعي أو على مسمى حقيقي
فإن كان الأول فلا إجمال لأن الصلاة اسم شرعي والشرع أخبر عن انتفاء ذلك المسمى عند انتفاء الوصف المخصوص
فإن قلت يقال هذه الصلاة فاسدة فدل على
بقاء المسمى مع الفساد وقال صلى الله عليه و سلم دعى الصلاة أيام أقرائك
قلت التوفيق بين الدليلين أن نصرف ذلك إلى المسمى الشرعي وهذا إلى المسمى اللغوي
ومن هذا الباب قوله لا نكاح إلا بولي و لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
أما إن كان المسمى حقيقيا فإما ان يكون له حكم واحد أو أكثر من حكم واحد
والأول
كقولنا لا شهادة لمجلود في قذف لأنه لا يمكن صرف النفي إلى ذات الشهادة لأنها قد وجدت فلا بد من صرف النفي إلى حكمها وليس لها إلا حكم واحد وهو الجواز لأن الشهادة إذا كانت فيما كانت ندبنا إلى ستره لم يكن لإقامتها مدخل في الفضيلة كقولنا لا إقرار لمن أقر بالزنا مرة واحدة لأن الأولى له أن يستر ذلك على نفسه فإذن لا حكم له إلا الجواز وإذا لم يكن له إلا هذا الحكم الواحد انصرف النفي إليه فصح التعلق بهأما إذا كان له حكمان الفضيلة والجواز فلم يكن صرفه إلى أحدهما أولى من الآخر فيتعين الإجمال هذا قول الأكثرين
ولقائل أن يقول لكن صرفه إلى الجواز أولى من صرفه إلى الفضيلة لوجوه
أحدها
أن المدلول عليه باللفظ نفي الذات والدال على نفي الذات دال على نفي جميع الصفات لاستحالة بقاء الصفة مع عدم الذاتفإذن قوله لا عمل يدل على نفي الذات وعلى نفي الصحة ونفي الكمال ترك العمل به في الذات فوجب أن يبقى معملا به في الباقي
فإن قلت اللفظ لم يدل على نفي الصحة بالمطابقة وإنما دل عليها بالالتزام ضرورة أنه يلزم من انتفاء الذات انتفاء الصفة ودلالة الالتزام تابعة لدلالة المطابقة
التي هي الأصل
فها هنا لما لم توجد دلالة المطابقة التي هي الأصل فكيف تبقى دلالة الالتزام التي هي الفرع
وأيضا
فقد جاء هذا اللفظ لنفي الفضيلة فقط والأصل في الكلام الحقيقةوالجواب عن الأول
أنه لا نزاع في أن دلالة هذا اللفظ على نفي الصفة تابعة لدلالته على نفي الذات لكن بعد استقرار تلك الدلالة صار اللفظ كالعام بالنسبة إليها بأسرهافإذا خص عنها في بعض الأمور وهو الذات
وجب أن يبقى معمولا به في الباقي
وعن الثاني
أنا بينا أن اللفظ عام بالنسبة إلى نفي الذات ونفي الصفات ثم تارة يختص بالنسبة إلى الذات فقط وحينئذ يفيد نفي بقية الأحكاموتارة يختص بالنسبة إلى الذات والصحة فيبقى معمولا به في الباقي وهو نفي الفضيلة
وثانيها
هو أن المشابهة بين المعدوم وبين ما لايصح أتم من المشابهة بين المعدوم وبين ما يوجد ويصح ولا يفضل والمشابهة إحدى أسباب المجاز فكان حمل اللفظ على نفي الصحة أولى
وثالثها
أن الخلل الحاصل في الذات عند عدم الصحة أشد من الخلل الحاصل فيها عند بقاء الصحة وعدم الفضيلة وإطلاق اسم العدم على المختل أولى من إطلاقه على غير المختلسلمنا أنه لا يجوز حمل النفي على هذه الأحكام ولا يجوز حمله على نفي الذات فلم قلت إنه مجمل
بيانه أن قولنا هذا الشيء لفلان معناه يعود نفعه إليه وقولنا لا عمل لمن لا نية له معناه نفعه إليه وهذا يقتضي نفي الصحة لأنه لو صح ذلك العمل لعاد نفعه إليه واللفظ دل على نقيضه والله أعلم
المسألة الرابعة
قال بعضهم آية السرقة مجملة في اليد وفي القطع أما اليد فلأنه يطلق اسم اليد على هذا العضو من أصل المنكب وعليه من الزند وعليه من الكوع وعليه من أصول الأناملوأما القطع فلأنه قد يراد به الشق فقط كما يقال برى فلان قلمه فقطع يده وقد يراد به الإبانة
والجواب عن الأول
أن اسم اليد موضوع لهذا العضو من المنكب ولا يتناول الكف وحده لأنه لا يقال قطعت يد فلان بالكلية إذا قطعت من الكف
وعن الثاني
أن القطع في اللغة الإبانة فأذا أضيف إلى شيء أفاد إبانة ذلك الشيءوالشق إذا حصل في الجلد فقد حصلت الإبانة في تلك الأجزاء بلى أطلق اسم اليد عليه على سبيل إطلاق اسم الكل على الجزء فيكون المجاز ها هنا في لفظ اليد لا في لفظ القطع والله أعلم
المسألة الخامسة
قيل في قوله عليه الصلاة و السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان إنه مجمل لأن نفس الخطأ غير مرفوع فلا بد من صرفه إلى الحكم فيلزم الإجمال على ما تقدم تقريرهوالأقرب أنه ليس بمجمل لأن المولى إذا قال لعبده
رفعت عنك الخطأ كان ذلك في العرف منصرفا إلى نفي المؤاخذة بذلك الفعل فكذا قال الرسول صلى الله عليه و سلم لأمته مثل هذا القول وجب أن ينصرف إلى ما يتوقع مؤاخذته لأمته به وهو الأحكام الشرعية فكأنه قال رفعت عنكم الأحكام الشرعية من الخطأ والله أعلم
القسم الثاني في المبين وفيه مسائل
المسألة الأولى في أقسام المبينالخطاب الذي يكفي نفسه في إفادة معناه إما أن يكون لأمر يرجع إلى وضع اللغة أو لا يكون كذلك
والأول كقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم
أما الثاني فإما أن يكون بيانه على سبيل التعليل أولا على سبيل التعليلاما التعليل فضربان
أحدهما
أن يكون الحكم بالمسكوت عنه أولى من الحكم بالمنطوق به كما في قوله تعالى فلا تقل لهما أفوثانيهما
كما في قوله صلى الله عليه و سلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات
وأما الذي لا يكون تعليلا فضربان
أحدهما
أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا بهوثانيهما
أن يظهرفي العقل تعذر إجراء الخطاب على ظاهره ويكون هناك أمر يكون حمل الخطاب عليه أولى من حمله على غيره كما في قوله تعالى واسأل القرية
فهذه أقسام المبين والله أعلم
المسألة الثانية في أقسام البيانات
أعلم أن بيان المجمل إما أن يقع بالقول أو بالفعل أو بالترك أما بالقول فظاهر
وأما بالفعل فإما أن يكون الدال على البيان شيئا يحصل بالمواضعة أو شيئا تتبعه المواضعة أو شيئا يتبع المواضعة
فالأول هو الكتاب وعقد الأصابع
فأما الكتابة فقد يقع بها البيان من الله تعالى بما كتب في اللوح المحفوظ ومن الرسول صلى الله عليه و سلم بما كتب إلى عماله
وأما عقد الأصابع فقد بين به الرسول صلى الله عليه و سلم إذ قال الشهر هكذا وهكذا وحبس في الثالثة أصبعه
وهذا الباب يستحيل على الله تعالى لاستحالة الجوارح عليه
وأما القسم الثاني وهو الذي تتبعه المواضعة فهو الإشارة لأن المواضعة
مفتقرة إليها وهي غير مفتقرة إلى المواضعة وإلا لافتقرت إلى إشارة أخرى ولزم التسلسل وهو محالوقد بين الرسول صلى الله عليه و سلم بالإشارة وذلك حين أشار إلى الحرير بيده وقال هذا حرام
على ذكور أمت حل لإناثها
وأما القسم الثالث وهو الذي يكون تابعا للمواضعة فهو كما إذا قال الرسول
صلى الله عليه و سلم هذا الفعل بيان لهذه الآية أو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي
واعلم أنه لا يعلم كون الفعل بيانا للمجمل إلا بأحد أمور ثلاثة
أحدها
أن يعلم ذلك بالضرورة من قصدهوثانيها
أن يعلم بالدليل اللفظي وهو أن يقول هذاالفعل بيان لهذا المجمل أو يقول أقوالا يلزم من مجموعها ذلك
وثالثها
بالدليل العقلي وهو أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا له ولا يفعل شيئا آخر فيعلم أن ذلك الفعل بيان للمجمل وإلا فقد أخر البيان عن وقت الحاجة وإنه لا يجوزوأما الترك فاعلم أن الفعل يبين الصفة ولا يدل على وجوبها وترك الفعل يبين نفي وجوبه وذلك على أربعة أضرب
أحدها
أن يقول من الركعة الثانية إلى الثالثة ويمضي على صلاته فيعلمأن هذا التشهد ليس بشرط في صحة الصلاة وإلا لم تصح مع عدم شرط الصحة ويدل على أنه ليس بواجب أنه صلى الله عليه و سلم لا يجوز أن يتعمد ترك الواجب
وثانيها
أن يسكت عن بيان حكم الحادثة فيعلم أنه ليس فيه حكم شرعيوثالثها
أن يكون ظاهر الخطاب متناولا له ولأمته على سواء فإذا ترك الفعل دل على أنه كان مخصوصا من الخطاب ولم يلزمه ما لزم أمتهورابعها
أن يتركه بعد فعله إياه فيعلم أنه قد نسخ عنهثم ينظر فإن كان حكم الأمة حكمه نسخ عنهم أيضا وإلا كان حكمهم بخلاف حكمه والله أعلم
المسألة الثالثة
الحق أن الفعل قد يكون بيانا خلافا لقوملنا
أن الخصم إما أن يقول إنه لا يصح وقوع البيان بالفعل أو يقول إنه يصح عقلا لكن لا يجوز في الحكمةوالأول ضربان
أحدهما أن يقال إن الفعل لا يؤثر في وقوع اليقين أصلاوالآخر أن يقال إنه لا يؤثر في ذلك إلا مع غيره
هو أن يقول الرسول صلى الله عليه و سلم هذا الفعل بيان لهذا الكلام
والأول باطل لأن فعل الرسول صلى الله عليه و سلم للصلاةوالحج أدل عليهما من صفته لهما فإنه ليس الخبر كالمعاينة ولهذا بين الرسول صلى الله عليه و سلم الحج والصلاة
وقال خذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وبين أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم الوضوء بفعلهم
وأما الثاني وهو أن لايقع البيان بالفعل وحده إلا عند قيام الدليل على أن ذلك الفعل بيان لذلك المجمل فهذا مما لا خلاف فيه إلا أن المبين هو الفعل لأنه هو المتضمن لصفة الفعل وإنما القول لتعليق الفعل الواقع بيانا على المجمل
وأما القسم الثاني وهو أنه غير جائز في الحكمة فهو لايستقيم على أصلنا
لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ثم إن سلمنا هذا الأصل لكنه لا يمتنع أن يعلم اللهتعالى من المكلف أن بيان المجمل بهذا الطريق أصلح له
احتج المخالف
بأن الفعل يطول فيلزم تأخير البيانوالجواب
أن القول قد يكون أطول لأن وصف أفعال الصلاة وتروكها على الاستقصاء أطول من الإتيان بركعة واحدة فجوابكم جوابنا والله أعلمالمسألة الرابعة
في أن القول هل يقدم على الفعل في كونه بياناالقول والفعل إذا وردا فإما أن يكونا متطابقين أو متنافيين فإن كانا متطابقين وعلم تقدم أحدهما على ألآخر فالأول بيان والثاني تأكيد لأن الأول قد حصل التعريف به فلا حاجة إلى الثاني
وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر حكم على الجملة بأن الأول منهما بيان والثاني تأكيد
وإن كانا متنافيين كقوله صلى الله عليه و سلم من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا مع ما روي عنه صلى الله عليه و سلم أنه قرن
فطاف طوافين وسعى سعيين
فالقول هو المقدم في كونه بيانا لأنه بيان بنفسه والفعل لا يدل حتى يعرف ذلك إما بالضرورة أو بالاستدلال بدليل قولي أو عقلي فإذا لم يعقل ذلك لم يثبت كون الفعل بيانا والله أعلم
المسألة الخامسةفي البيان كالمبين هذا الباب يشتمل على شيئين
أحدهما هل البيان كالمبين في القوةوالآخر هل هو كالمبين في الحكم
أما الأول فقال الكرخي المبين إذا كان لفظا معلوما
وجب كون بيانه مثله وإلا لم يقبل
والحق أنه يجوز أن يكون البيان والمبين معلومين وأن يكونا مظنونين أن يكون المبين معلوما وبيانه مظنونا كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد والقياس
وأما الآخر فهو أنه هل إذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا كذلك
قال به قوم فإن أرادوا به أن المبين إذا كان واجبا فبيانه بيان لصفة شيء واجب فصحيح
وإن أرادوا به أنه يدل على الوجوب كما يدل المبين فغير صحيح لأن البيان إنما يتضمن صفة المبين وليس يتضمن لفظا يفيد الوجوب
ألا ترى أن صورة الصلاة ندبا واجبا صورة واحدة
وإن أرادوا أنه إذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا على الرسول صلى الله عليه و سلم وإذا لم يكن الفعل المبين واجبا لم يكن بيانه واجبا على الرسول صلى الله عليه و سلم فباطل لأن بيان المجمل واجب سواء تضمن فعلا واجبا أو لم يتضمن وإلا كان تكليفا بمالا يطاق والله أعلم
القسم الثالث في وقت البيان وفيه مسائل
المسألة الأولىالقائلون بأنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن التكليف به مع عدم الطريق إلى العلم به تكليف بمالا يطاق
والإشكالات التي ذكرناها في أن تكليف الساهي غير جائز قائمة ها هنا والجواب واحد
المسألة الثانية
اختلفوا في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب الخطاب المحتاج إلى البيان ضربانأحدهما ما له ظاهر قد استعمل في خلافه
والثاني لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركةوالأول أقسام
أحدها تأخير بيان التخصيصوثانيها تأخير بيان النسخ
وثالثها تأخير بيان الأسماء الشرعيةورابعها تأخير بيان اسم النكرة إذ أراد به شيئا معينا
إذا عرفت ذلك فنقولمذهبنا أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في كل هذه
الأقسام
وأما المعتزلة فأكثر من تقدم أبا الحسين رحمه الله اتفقوا على المنع من تأخير البيان في كل هذه الأقسام إلا في النسخ فإنهم جوزوا تأخير بيانه
وأما أبو الحسين فإنه منع من تأخير البيان فيما له ظاهر قد استعمل في خلافه وزعم أن البيان الإجمالي كاف فيه وهو أن يقول عند الخطاب اعلموا أن هذا العموم مخصوص وأن هذا الحكم سينسخ بعد ذلك
وأما البيان التفصيلي فإنه يجوز تأخيره
وأما الذي لا يكون له ظاهر مثل الألفاظ المتواطئة والمشتركة فقد جوز فيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة
وهذا التفصيل ذكره كثير من فقهاء أصحابنا كأبي بكر القفال وأبي اسحاق المروزي وأبي بكر الدقاق
واعلم أن الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين
أحدهما
أن يستدل في الجملة على جواز تأخير البيان عن وقت الخطابوثانيهما
أن يستدل على جواز ذلك في كل واحدة من الصور المذكورةأما المقام الآول فالدليل عليه قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا
قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وثم في اللغة للتراخي وهو المطلوبفإن قيل لا نسلم أن كلمة ثم للتراخي فقط بل قد تجيء بمعنى الواو كقوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب ثم كان من الذين آمنوا ثم
الله شهيد
سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن المراد بالبيان في هذه الآية البيان الذي اختلفنا فيه وهو بيان المجمل والعموم فلم لا يجوز أن يكون المراد به إظهاره بالتنزيل غاية ما في الباب أن يقال هذا مخالفة الظاهر لكن نقول يلزم من حفظ هذا الظاهر مخالفة ظاهر آخر وهو أن الضمير الذي في قوله ثم إن علينا بيانه راجع إلى جميع المذكور وهو القرآن
ومعلوم أن جميعه لا يحتاج إلى البيان فليس حفظ أحد الظاهرين بأولى من الآخر وعليكم الترجيح
سلمنا أن المراد من البيان ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون المراد به تأخير البيان التفصيلي وذلك عند أبي الحسين جائز
سلمنا أن المراد مطلق البيان لكن لم لا يجوز أن يكون المراد من قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه هو أن يجمعه في اللوح المحفوظ ثم إنه بعد ذلك ينزله على الرسول صلى الله عليه و سلم ويبينه له وذلك متراخ عن الجمع
سلمنا أن البيان مذكرتموه لكن الآية تدل على وجوب تأخير
البيان وذلك مالم يقل به أحد فما دلت عليه الآية لا تقولون به وما تقولون به وهو الجواز لم تدل الآية عليه فبطل الاستدلال
والجواب
أما أن كلمة ثم للتراخي فذلك متواتر عند أهل اللغة والآيات التي تلوتموها المراد هناك التأخير في الحكمقوله لم لا يجوز أن يكون المراد من البيان إظهاره بالتنزيل
قلنا لأن قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أمر للنبي صلى الله عليه و سلم باتباع قرآنه وإنما يكون مأمورا بذلك بعد نزوله عليه فإنه قبل ذلك لا يكون عالما به فكيف يمكنه اتباع قرآنه
فثبت أن المراد من قوله فإذا قرآناه هو الإنزال ثم إنه تعالى حكم بتأخير البيان عن ذلك وذلك يقتضي تأخير البيان عن وقت الإنزال وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون المراد من البيان هو الإنزال لاستحالة كون الشيء سابقا على نفسه
سلمنا أنه يمكن ما ذكروه ولكنه خلاف الظاهر
قوله يلزم من مخالفة المحافظة على هذا الظاهر احتياج القرآن جميعه إلى البيان
قلنا لا نسلم فإن لفظ القرآن يتناول كله وبعضه بدليل
انه لو حلف أن لا يقرأ القرآن ولا يمسه فقرأ آية أو لمس آية فإنه يحنث في يمينه
سلمنا أن لفظ القرآن ليس حقيقة في البعض لكن إطلاق اسم الكل على البعض أسهل من إطلاق لفظ البيان على التنزيل لأن الكل مستلزم للجزء والبيان غير مستلزم للتنزيل
قوله نحمله على البيان التفصيلي
قلنا اللفظ مطلق فتقييده خلاف الظاهر
قوله لم لا يجوزأن يكون المراد من الجمع جمعه في اللوح المحفوظ
قلنا لما بينا أنه تعالى أخر البيان عن القراءة التي يجب على النبي عليه الصلاة و السلام متابعتها وذلك يستدعي تأخير البيان عن وقت الإنزال
قوله هذا يقتضي وجوب تأخير البيان
قلنا ونحن نقول به
فإن قلت الضمير عائد إلى كل القرآن فيجب تأخير بيان الكل وذلك لم يقل به أحد
قلت قد تقدم بيان أن الضمير غير عائد إلى الكل والله أعلم
أما الذي يدل على كل واحدة من الصور التي ذكرناها فنقول
الدليل على أنه يجوز تأخير البيان في النكرة أن الله تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة موصوفة غير منكرة ثم أنه لم يبينها لهم حتى سألوا سؤالا بعد سؤال
إنما قلنا إنه لم يرد بقرة منكرة لوجهين
الأول
أن قوله تعالى أدع لنا ربك يبين لنا ما هي و ما لونها وقول الله تعالى إنها بقرة لا فارض ولا بكر إنها بقرة صفراء إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ينصرف إلى ما أمروا بذبحه من قبل وهذه الكنايات تدل على أن المأمور به ما كان ذبح بقرة منكرة بل ذبح بقرة معينةالثاني
أن الصفات المذكورة في الجواب عن السؤال الثاني إما أن يقال إنها صفات البقرة التي أمروا بذبحها أو لا أو صفات بقرة وجبت عليهم عند ذلك السؤال وانتسخ ما كان واجبا عليهم قبل ذلك والأول هو المطلوب والثاني يقتضي أن يقع الاكتفاء بالصفات المذكورة آخرا وأن لا يجب حصول الصفات المذكورة قبل ذلك ولما أجمع المسلمون على أن تلك الصفات بأسرها كانت معتبرة علمنا فساد هذا القسم
فإن قيل لا يجوز التمسك بهذه الآية لأن الوقت الذي أمروا فيه بذبح البقرة كانوا محتاجين إلى ذبحها فلو أخر الله البيان لكان ذلك تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وأنه لا يجوز
فإذن ما تقتضيه الآية لا تقولون به وما تقولون به لا تقتضيه الآية
نزلنا عن هذا المقام لكن لا نسم أن المأمور به كان ذبح بقرة موصوفة بل ذبح بقرة كيف كانت فلما سألوا تغيرت المصلحة
ووجبت عليهم بقرة أخرى
وأما الكنايات فلا نسلم عودها إلى البقرة ولم لا يجوز أن يقال إنها كنايات عن القصة والشأن وهذه طريقة مشهورة عند العرب
سلمنا أن هذه الكنايات تقتضي كون البقرة المأمور بها موصوفة لكن ها هنا ما يدل على كونها منكرة وهو من ثلاثة أوجه
الأول
أن قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أمربذبح بقرة مطلقة وذلك يقتضي سقوط التكليف بذبح بقرة أي بقرة كانت وذلك يقتضي أن يكون اعتبار الصفة بعد ذلك تكليفا جديداالثاني
لو كان المراد ذبح بقرة معينة لما استحقوا التعنيف على طلب البيان بل كانوا يستحقون المدح عليه فلما عنفهم الله تعالى في قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون علمنا تقصيرهم في الإتيان بما أمروابه أولا وذلك إنما يكون لو كان المأمور به أولا ذبح بقرة منكرة
الثالث
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو ذبحوا أية بقرة أرادوا لأجزأت عنهم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم سلمنا أن المأمور به ذبح بقرة معينة موصوفة لكن لم لا يجوز أن يقال البيان التام قد تقدم لكنهم لم يتبينوا لبلادتهم فاستكشفوا طلبا للزيادة فحكى الله تعالى ذلك
سلمنا أن البيان التام لم يتقدم فلم لا يجوز أن يقال إن موسى عليه السلام كان قد أعلمهم بأن البقرة ليست مطلقة بل معينة فطلبوا البيان التفصيلي
فالحاصل أن البيان الإجمالي كان مقارنا والبيان التفصيلي كان متأخرا وهو جائز عند أبي الحسين رحمه الله والجواب قوله الآية تقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة
قلنا لا نسلم لأن ذلك إنما يلزم لو كان الأمر مقتضيا للفور لكنا لا نقول به
قوله الكنايات عائدة إلى القصة والشأن
قلنا هذا باطل لوجوه
أحدها
أن هذه الكنايات لو كانت عائدة إلى القصة والشأن لكان الذي يبقى بعد ذلك غير مقيد لأنه لا فائدة في قوله بقرة صفراء بل لا بد من إضمار شيء آخر وذلك خلاف الأصلأما إذا جعلناالكنايات عائدة إلى المأموربه أولا لم يلزم هذا المحذور
وثانيها
أن الحكم برجوع الكنايات إلى القصة والشأن خلاف الأصل لأن الكناية يجب عودها إلى شيء جرى ذكره والقصة والشأن لم يجر ذكرهما فلا يجوز عود الكناية إليهما لكنا خالفنا هذا الدليل للضرورة في بعض المواضع فيبقى فيما عداه على الأصلوثالثها
أن الضمير في قوله تعالى مالونها و ماهي لا شك أنه عائد إلى البقرة المأمور بها فوجب أن يكون الضمير في قوله إنها بقرة صفراء عائدا إلى تلك البقرة وإلا لم يكن الجواب مطابقا للسؤالقوله إن قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أمر بذبح بقرة
مطلقة
قلنا هب أن ظاهره يفيد الإطلاق ونحن نسلمه لكنا نقول المراد كان غير الظاهر مع أنه تعالى ما بينه فما قلتموه لا يضرنا
قوله لو كان ذلك لطلب البيان لما استحقوا التعنيف بقوله وما كادوا يفعلون
قلنا إن قوله تعالى وما كادوا يفعلون ليس فيه دلالة على أنهم فرطوا في أول القصة أو أنهم كادوا يفرطون بعد استكمال البيان بل اللفظ محتمل لكل واحد منهما فنحمله على الأخير وهو أنهم لما وقفوا على تمام البيان توقفوا عند ذلك وما كادوا يفعلون
قوله نقل عن ابن عباس أنه قال شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم
قلنا هذا من أخبار الآحاد ومع تقدير الصحة فلا يصلح معارضا لنص الكتاب
قوله لم لا يجوز أن يقال كان البيان حاصلا لكنهم لم يتبينوا قلنا لوجهين
الآول
أنهم كانوا يلتمسون البيان ولو كان البيان حاصلا لما التمسوه بل كانوا يطلبون التفهيمالثاني
أن فقد التبيين عند حضور هذا البيان متعذر ها هنا لأن ذلك البيان ليس إلا وصف تلك البقرة والعاقل العارف باللغة إذا سمع تلك الأوصاف استحال أن لا يعرفها
قوله كانوا يطلبون البيان التفصيلي
قلنا لو كان كذلك لذكره الله تعالى أزالة للتهمة
أما الدليل على جواز تأخير بيان المخصص فالنقل
أما النقل فهو أن الله تعالى لما أنزل قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال ابن الزبعري قد عبدت الملائكة وعبد المسيح فهؤلاء حصب جهنم فتأخر بيان ذلك حتى أنزل الله تعالى قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنىفإن قيل لا نسلم أن قوله تعالى وما تعبدون من دون الله يندرج فيه
الملائكة والمسيح
وبيانه من وجهين
الأولأن كلمة ما لما لا يعقل فلا يدخلها المسيح والملائكة
الثاني
أن قوله تعالى إنكم وما تعبدون خطاب مع العرب وهم ما كانوا يعبدون المسيح والملائكة بل كانوا يعبدون الأوثانسلمنا ذلك لكن تخصيص العام بدليل العقل جائز وها هنا
دل العقل على خروج الملائكة والمسيح فإنه لا يجوز تعذيب المسيح بجرم الغير وهذا الدليل كان حاضرا في عقولهم
ثم نقول المسألة علمية وهذا خبر واحد فلا يجوز إثباتها به
سلمنا صحة الرواية لكن الرسول عليه السلام إنما سكت انتظارا لنزول الوحي عليه في تأكيد البيان العقلي واللفظي
والجواب
لا نسلم أن صيغة ما مختصة بغير العقلاء والدليل عليه وجوهأحدها
قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى والسماء وما بناها ولا أنتم عابدون ما أعبد
وثانيها
اتفاق أهل اللغة على ورود ما بمعنى الذي وكلمة الذي متناولة للعقلاء فكلمة ما أيضا كذلكوثالثها
أن ابن الزبعري كان من الفصحاء فلولا أن كلمة ما تتناول المسيح والملائكة وإلا لما أورده نقضا على الآيةورابعها
أن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يرد عليه ذلك بل سكت وتوقف إلى نزول الوحي ولو كان ذلك خطأ في اللغة لما سكت الرسول صلى الله عليه و سلم عن تخطئتهوخامسها
أنه يقال ما في ملكي فهو صدقة وما في بطن جاريتي فهو حر وهو يتناول الإنسان
وسادسها
أنها لو كانت مختصة بغير من يعلم لما كان لقوله تعالى من دون الله فائدة لأنه إنما يحتاج إلى الاحتراز حيث يصلح الاندراجقوله الخطاب كان مع العرب وهم ما كانوا يعبدون الملائكة والمسيح
قلنا الرواية المشهورة أنه قد كان من العرب من يعبد الملائكة والمسيح وقد ذكر الواحدي وغيره ذلك في سبب نزول
هذه الآية
ولأن هذه الآية لو كانت خطابا مع عبدة الأوثان فقط لما جاز توقف النبي صلى الله عليه و سلم عن تخطئة السائل
قوله كل أحد يعلم أن تعذيب الرجل بجرم الغير لا يجوز
قلت نعم لكن ألا يصح دخول الشبهة في أن أولئك المعبودين كانوا راضين بذلك أم لا وعند ذلك يصح السؤال
قوله هذه الرواية من باب الآحاد
قلنا لا نسلم فإن المفسرين اتفقوا على ذكرها في سبب نزول هذه الآية وذلك يدل على الإجماع
سلمنا أنه من الآحاد لكنا بينا أن التمسك بالأدلة اللفظية
أينما كان لا يفيد إلا الظن ورواية الآحاد صالحة لذلك والله أعلم
وأما المعقول فمن وجهين
أحدهما
وهو أن نقول لأبي علي وأبي هاشم لو لم يجز تأخير بيان التخصيص في الأعيان لما جاز تأخير بيان التخصيص في الأزمان لكن جاز هذا فجاز ذلكبيان الملازمة أنه لو لم يجز تأخير بيان المخصص في الأعيان لكان ذلك لأن تأخيره يوهم العموم وهو جهل وهذا المعنى قائم في تأخير المخصص في الآزمان فعدم الجواز هناك يقتضي عدم الجواز ها هنا
فإن قيل الفرق من وجهين
الأول
أن الخطاب المطلق معلوم أن حكمه مرتفع لعلمنا بانقطاع سبب التكليف وليس كذلك المخصوصوثانيهما
أن احتمال النسخ في المستقبل لا يمنع المكلف في الحال من العمل أما أن احتمال التخصيص في الحال يمنعه من العمل لأنه لا يدري أنه هل هو مندرج تحت الخطاب أم لاوالجواب عن الأول
أن الله تعالى لو قال لنا صلوا كل يوم جمعة لاقتضى ظاهره الدوام فإذا خرج منه ما بعد الموتللدلالة بقي الباقي على ظاهره فإن جاز أن يكون حكم الخطاب مرتفعا مع الحياة والتمكن ولا يدل البتة على ذلك وإن كان ظاهر الخطاب يتناوله جاز مثله في العموم
وعن الثاني
أن الفرق الذي ذكرتموه إنما يظهر لو أخر الله تعالى البيان عن وقت الحاجة أما إذا أخره عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة لم يجب على المكلف الاستغال بالفعل فلا حاجة في ذلك الوقت إلى تمييز المكلف به غن غيره كما لا حاجة هناك إلى تمييز وقت التكليف عن غيرهالدليل الثاني
أجمعنا على أنه يجوز أن يأمر الله تعالى المكلفين بالأفعال مع أن كل واحد منهم يجوز أن يموت قبل وقت الفعل فلايكون مرادا بالخطاب وفي ذلك تشكيك فيمن أريد بالخطاب وهذا هو تخصيص ولم يتقدم بيانه
واحتج أبو الحسين رحمه الله على المنع من تأخير بيان ماله ظاهر إذا
استعمل في غيره بوجهينالأول
أن العموم خطاب لنا في الحال بالإجماع والمخاطب إما أن لا يقصد إفهامنا في الحال أو يقصد ذلك
والأول باطل لوجوه 4 أحدها
إنه إن لم يقصد إفهامنا انتقض كونه مخاطبا لأن المعقول من قولنا إنه مخاطب لنا أنه قد وجه الخطاب نحونا ولا معنى لذلك إلا أنه قصد إفهامنا
وثانيها
أنه لو لم يقصد إفهامنا في الحال مع أن ظاهره يقتضي كونه خطابا لنا في الحال لكان قد أغرانا بأن نعتقد أنه قد قصد إفهامنا في الحال فيكون قد قصد أن نجهل لأن من خاطب قوما بلغتهم فقد أغراهم بأن يعتقدوا فيه أنه قد عنى ما عنوهوثالثها
أنه لو لم يقصد إفهامنا لكان عبثا لأن الفائدة في الخطاب إفهام المخاطبورابعها
أنه لو جاز أن لا يقصد إفهامنا بالخطاب جازت مخاطبة العربي بالزنجية وهو لا يحسنها إذا كان غير واجب إفهام المخاطبين بل ذلك أولى بالجواز لأن الزنجية ليس لها ظاهرعند العربي يدعوه إلى اعتقاد معناه ولو جازت مخاطبة العربي بالزنجية وبين له بعد مدة جازت مخاطبة النائم وبين له بعد مدة ان يقصد الإنسان بالتصويت والتصفيق شيئا يبينه بعد مدة
فإن قلت خطاب الزنج لا يفهم منه العربي شيئا فلم يجز أن يخاطبوا به وليس كذلك خطاب العربي بالمجمل لأن العربي يفهم منه شيئا ما لأن قول الله تعالى وأقيموا الصلاة قد فهم منه الأمر بشيء وإن لم يعرف ما هو
قلت فإن جاز أن يكون اسم الصلاة واقعا على الدعاء ويريد الله به غيره ولا يبين لنا جاز أن يكون ظاهر قوله تعالى أقيموا للأمر ولا يستعمله في الأمر
ولا يبين لنا ذلك وفي ذلك مساواته لخطاب الزنج لأنا لا نفهم منه شيئا أصلا
وأما القسم الثاني وهو أنه أراد إفهامنا في الحال فلا يخلو إما أن يريد
أن يفهم أن مراده ظاهره أو غير ظاهره فإن أراد الآول فقد أراد منا الجهلوإن أراد الثاني فقد أراد منا مالا سبيل إليه
ثم قال أبو الحسين وهذه الدلالة تتناول العام المستعمل في الخصوص والمطلق المفيد للتكرار المنسوخ والأسماء والنقولة إلى الشريعة والنكرة إذا أريد بها شيء معين لأن الكل مستعمل في خلاف ظاهره
الثاني
لو جاز أن يريد بالعموم الخصوص ولا يبين لنا ذلك في الحال ولا يشعرنا بأنه بخلافه لم يكن لنا طريق إلى معرفة وقت الفعل الذي يقف وجوب البيان عليه لأنه لو قيل لنا صلوا غدا جوزنا أن يكون المراد بقوله غدا بعد غد وما بعده أبدا لأن كل ذلك يسمى غدا مجازا ولا يبينه لنا فلا يقف وجوب البيان على غاية وفيه تعذر علمنا بالمراد بالخطابفإن قلت إذا بين في غد صفة العبادة ثم قال افعلوها الآن علمنا أنه يجب فعلها في ذلك الوقت
قلت لا يصح لكم ذلك لأنه يجوز أن يكون عنى بقوله
الآن وقتامتراخيا على طريق المجاز ولا يبينه لنا في الحال كما جاز مثله في سائر الألفاظ
والجواب عن الأول
من حيث المعارضة ومن حيث الجواباما المعارضة فمن ثلاثة أوجه
أحدها
أن العموم خطاب لنا في الحال مع أنه لا يجوز اعتقاد استغراقه عند سماعه بل لا بد من أن نفتش الأدلة السمعية والعقلية فننظر هل فيها ما يخصه أم لا فإن لو يوجد فيها ما يخصه قضى بعمومه وفي زمان التوقف الخطاب بالعموم قائم مقامه مع أنه لايجوز اعتقاد ظاهره فانتقض قولكمأجاب أبو الحسين رحمه الله عنه بأن من لم يجوز أن يسمع الكلف العام دون الخاص لا يلزمه هذا السؤال ومن جوز ذلك فله أن يجيب عن السؤال بأن ما يعلمه المكلف من كثرة الأدلة والسنن يجوز معه أن يكون فيها ما يدل على أن المراد بالخطاب غير ظاهره فيصير ذلك كالإشعار بالتخصيص
والجواب
أما أنه لا يجوز أن يسمع المكلف العام دون الخاص فهذا المذهب باطل عندك وتخريج النقض بالمذهب الباطل باطل وأما قوله علمه بكثرة السنن كالإشعار بالتخصيصقلنا فإذا جوزت أن يكون تجويزه لقيام المخصص في الحال مانعا له من اعتقاد الاستغراق في الحال فلم
لا يجوز أن يكون تجويزه لحدوث المخصص في ثاني الحال مانعا له من اعتقاد الاستغراق في الحال فهذا أول المسألة
وثانيها
أجمعنا على أنه يجوز تأخير بيان المخصص بزمان قصير وأن تعطف جملة من الكلام على جملة أخرى ثم تبين الجملة الأولى عقيب الثانية وأن يبين المخصص بالكلام الطويل وهذه الصور الثلاثة نقض على ما ذكرهفإن قلت إنا لا نجوز تأخير البيان إلا مقدار ما لا ينقطع عن السامع توقع شرط يرد على الكلام وإنما نجوز
البيان بالطويل من القول أو الفعل إذا لم يتم البيان إلا بهما وإذا لم يتم إلا كذلك لم يكن فيه تأخير البيان
قلت إن ظاهر لفظ العموم يفيد الاستغراق فحال ما سمع ذلك اللفظ يتوجه عليه التقسيم الذي ذكره أبو الحسين من أنه إما أن يكون غرض المخاطب به الإفهام أو لا يكون غرضه الإفهام والثاني باطل فتعين الأول
فإما أن يكون غرضه إفهام ماأشعر به الظاهر فيكون مريدا للجهل أو غيره فيكون طالبا ما لا سبيل إليه
فإن قلت تجويز السامع أن يأتي المتكلم بعد ذلك الكلام بشرط أو استثناء يمنعه من حمل هذا اللفظ على ظاهره
قلت فلم لا يجوز أن يقال في مسألتنا تجويز السامع أن يأتي المتكلم حال إلزام التكليف بدليل مخصص يمنعه من حمل اللفظ على ظاهره وهذا أول المسألة
وثالثها
أنا نجوز أن يأمر الله تعالى المكلفين بالأفعال مع أن كل واحد منهم يجوز أن يموت قبل وقت الفعل فلا يكون مرادا بالخطاب وفي ذلك شككنا فيمن أريد بالخطاب وهذا تخصيص لم يتقدم بيانه البتةورابعها
أن غير أبي الحسين من المعتزلة اتفقوا على جواز تأخير بيان النسخ إجمالا وتفصيلا وحينئذ ينتقض دليلهم به لأن اللفظ إذا أفاد الدوام مع أن الدوام غير مراد فإن أراد ظاهرهفقد أراد الجهل وإن أراد غير ظاهره فقد أراد ما لاسبيل إليه وما يذكرونه من الفرق فقد ذكرناه وأجبنا عنه
وأما من حيث الجواب فمن وجهين
الأولأن نقول ما المراد من قولك المخاطب إما أن يكون غرضه إفهامنا أو لا يكون غرضه ذلك
إن عنيت بالإفهام إفادة القطع واليقين فليس غرضه ذلك بل غرضه منه الإفهام بمعنى إفادة الاعتقاد الراجح والظن الغالب الغالب مع تجويز نقيضه
فلم قلت إنه على هذا التقدير يكون عابثا ويكون مغريا بالجهل
وبهذا الجواب يظهر الفرق بين ما إذا كان الغرض ذلك
وبين خطاب العربي بالزنجية لأن هناك لا يمكن أن يكون الغرض إفادة الاعتقاد الراجح فإنه لا يفهم منه شيئا
وإن عنيت به أن غرضه إفادة الاعتقاد الراجح كيف كان أعني القدر المشترك بين الاعتقاد الراجح المانع من النقيض وبين الاعتقاد الراجح المجوز للنقيض فهذا مسلم ولكن هذا القدر لا يمنع من ورود المخصص لأنه لو امتنع لكان ذلك الاعتقاد مانعا من النقيض مع أنا فرضناه غير مانع منه
ثم الذي يدل على أن الغرض من الخطاب إفادة أصل الاعتقاد الراجح لاإفادة الاعتقاد الراجح المانع من النقيض هو أن دلالة الأدلة اللفظية تتوقف على كون النحو واللغة والتصريف منقولا بالتواتر على عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص
والنسخ والإضمار والنقل والتقديم والتأخير وعدم المعارض العقلي والنقلي وكل هذه المقدمات طني وما يتوقف على الظني أولى أن يكون ظنيا
فثبت أن الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الاعتقاد الراجح وهذا القدر لا ينافيه احتمال ورود المخصص بعده
ومما يحقق ذلك أن الغيم الرطب في الشتاء يفيد ظن نزول المطر ثم قد لا يوجد في بعض الأوقات ثم لا يكون هذ العدم قادحا في ذلك الظن وإلا لتوقف تحقق ذلك الظن على انتفاء هذا العدم
فحينئذ يكون ذلك الظن قطعا لا ظنا هذا خلف فكذا ها هنا اللفظ العام لا يفيد إلا ظن الاستغراق وهذا القدر لا يمنع من حدوث المخصص والله أعلم
الوجه الثاني في الجواب
أن اللفظ العام إن وجد مع المخصص دل المجموع الحاصل منه ومن ذلك المخصص على الخاصوإن وجد خاليا عن المخصص دل هو مع عدم المخصص على الاستغراق وذلك متردد بين هاتين الحالتين على السواء فهو بالنسبة إلى هاتين الحالتين كاللفظ المشترك بالنسبة إلى مفهوماته والمتواطىء بالنسبة إلى جزئياته فكما أنه يجوز عند أبي الحسين ورود اللفظ المشترك والمتواطىء خاليا عن البيان لأنه يفيد أن المراد أحد تلك المسميات فكذا ها هنا اللفظ العام قبل العلم بأنه وجد معه المخصص أو عدم نعلم أن المراد إما العموم أو الخصوص ونعلم أن هذا اللفظ إن وجد معه المخصص أفاد الخاص وإن وجد معه عدم المخصص أفاد العام فلا
فرق بينه وبين المشترك فكما جاز تأخير البيان هناك جاز ها هنا
فإن قلت هذا عود إلى القول بأن هذه الصيغة مشتركة بين العموم والخصوص ونحن الآن في التفريغ على أنها للعموم فقط
قلت لا نسلم أن هذا عود إلى القول بالاشتراك وذلك لأنا نسلم أنها وحدها موضوعة للاستغراق
وبهذا الكلام انفصلنا عن القائلين بالاشتراك لكنا نقول لا نزاع في حسن ورود المخصص ولا نزاع في أنه عند ورود المخصص لا يفيد إلا الخاص فإذا شككنا في وجود المخصص وعدمه لزمنا أن نشك في أنه هل يفيد الاستغراق أم لا لأن الشك في الشرط شك في المشروط فأين هذا القول من مذهب القائلين بالاشتراك
والجواب عن الثاني
أن اللفظ وإن كان محتملا إلا أنه قد يوجد من القرائن ما يفيد القطع بأن المراد من اللفظ ظاهرهوعلى هذا التقدير يزول السؤال
فإن لم يوجد شيء من هذه القرائن وحضر الوقت الذي دل ظاهر الصيغة على أنه وقت العمل وجب عليه العمل لأن الظن قائم مقام العلم في اقتضاء وجوب العمل في الحال ولكنه لا يقوم مقامه فيما لا يتعلق به العمل فظن كون اللفظ دالا على وجوب العمل في الحال يكفي في القطع بوجوب العمل في الحال ولكن ظن عدم المخصص لا يكفي في القطع بعدم المخصص فظهر الفرق والله أعلم
المسألة الثالثة
وأما الخطاب الذي لا ظاهر له وهو الاسم المشترك كالقرء بين الطهر والحيض فإن له ظاهرا من وجه دون وجه
أما الوجه الذي يكن ظاهرا فيه فهو أنه يفيد أن المتكلم لم يرد شيئا غير الطهر وغير الحيض وأنه أراد إما هذا وإما هذافمن هذا الوجه لا يحتاج إلى بيان
وأما الوجه الذي يكون غير ظاهر فهو أنه لا يفيد أي الأمرين إرادة المتكلم الطهر أو الحيض ولا يجب أن يقترن به بيان في الحال
والدليل عليه
أن الاسم المشترك يفيد أن المراد إما هذا وإما هذا من غير تعيين وهذا القدر يصلح أن يراد تعريفه لأن الإنسان قد يقول لغيره لي إليك حاجة مهمة أوصيك بها ولا يكون غرضه في الحال إلا الإعلام بهذه الجملة
وقد يقول رأيت رجلا في موضع كذا وهو يكره وقوف السامع على عينه أو يكره وقوفه عليه من جهته ولهذا وضع في اللغة ألفاظ مهمة كما وضعت ألفاظ لمعان معينة قال الله تعالى ورسلا لم نقصصهم عليك فيضاعفه له أضعافا كثيرة
وأيضا
فقد يحسن من الملك أن يدعو بعض عماله فيقول له قد وليتك البلد الفلاني فاخرج إليه في غد وأنا أكتب إليك بتفصيل ما تعمله ويحسن من أحدنا أن يقول لغلامه أنا آمرك أن تخرج إلى السوق يوم الجمعة وتبتاع ما أبينه لك يوم الجمعة ويكون القصد بذلك التأهب لقضاء الحاجة والعزم عليهاوهذا هو نظير ما اخترناه من تأخير بيان المجمل
وإذا كان كذلك ثبت أنه يجوز إطلاق اللفظ المشترك من غير بيان التعيين
فإن قلت الغرض من التكليف هو الفعل والعلم والاعتقاد تابعان وهذا الإبهام يخل بالتمكين من الفعل
قلت الغرض من التكليف قبل الوقت هو العلم لا الفعل فأما في وقت الحاجة فالغرض هو الفعل وهناك يجب البيان
احتجوا
بأنه لو حسنت المخاطبة بالاسم المشترك من غير بيان في الحال لحسنت مخاطبة العربي بالزنجية مع القدرة عل مخاطبته بالعربية ولا يبين له في الحال والجامع أن السامع لا يعرف مراد المتكملم بهما على حقيقته
فإن قلت الفرق أن العربي لا يفهم من الزنجية شيئا وها هنا يفهم أن المراد أحد معنيي الاسم
قلت إما أن تعتبروا في حسن الخطاب حصول العلم بكمال المراد أو تكتفوا بمعرفة المراد من بعض الوجوه
والأول
يقتضي امتناع تأخير بيان المجملوالثاني
يوجب حسن مخاطبة العربي بالزنجية لأن العربي إذا عرف لغة الزنجي المخاطب له علم أنه قد أراد بخطابه شيئا ما إما الأمر وإما النهي وإما غيرهما
والجواب
أن المعتبر في حسن الخطاب أن يتمكن السامع من أن يعرف به ما أفاده الخطاب وهذا التمكن حاصل في ا لاسم المشترك لأنه موضوع لأحد هذين المعنيين والراجع فهم ذلك منه بخلاف العربي فإنه لا يتمكن من أن يعرف ما وضع له خطاب الزنج فوضح الفرق والله أعلمالمسألة الرابعة
يجوز أن يؤخر الرسول عليه السلام تبليغ ما يوحى إليه إلى وقت الحاجةوقال قوم يجب تقديمه عليه
لنا
أن في المشاهد قد يكون تقديم الإعلام على حضور وقت العمل قبيحا وقد يكون ترك التقديم قبيحا وقد يكون بحيث يجوز الأمرانوإذا كان كذلك لم يمتنع أن يعلم الله تعالى اختلاف مصلحة المكلفين في تقديم الإعلام وفي تركه فيلزم أن لا يكون التقديم واجبا على الإطلاق
احتجوا
بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والأمر للفوروالجواب
لا نسلم أنه للفور سلمناه لكن المراد بذلكهو القرآن لأنه هو الذي يطلق عليه القول بأنه منزل من الله تعالى والله أعلم
القسم الرابع في المبين له
وفيه مسائلالمسألة الأولى
الخطاب المحتاج إلى البيان يجب بيانه لمن أراد الله إفهامه دون من لم يرد أن يفهمهأما الأول
فلأنه لو لم يبينه له لكان قد كلفه ما لا سبيل له إلى العلم بهوأما الثاني
فلأنه لا تعلق له بذلك الخطاب فلا يجب بيانه لهثم الذين أراد الله منهم فهم خطابه ضربان
أحدهما
أراد منهم فعل ما تضمنه الخطاب إن كان ما تضمنه الخطاب فعلاوالآخر
لم يرد منهم الفعلوالأولون هم العلماء وقد أراد الله تعالى أن يفهموا مراده بآية الصلاة وأن يفعلوها
والآخرون هم العلماء في أحكام الحيض
فقد أريد منهم فهم الخطاب ولم يرد منهم فعل ما تضمنه الخطاب
والذين لم يرد الله تعالى أن يفهموا مراده
ولم يوجب ذلك عليهم ضربان
أحدهما
لم يرد منهم أن يفعلوا ما تضمنه الخطابوالآخر أراد منهم الفعل
والأولون هم أمتنا مع الكتب السالفة لأن الله تعال ما أراد أن يفهموا مراده بها ولا أن يفعلوا مقتضاها
والآخر هو النساء في أحكام الحيض لأن الله تعالى أراد منهن التزام أحكام الحيض بشرط أن يفتيهن المفتي ولم يوجب عليهن فهم المراد بالخطاب لأنه لم يوجب عليهن سماع أخبار الحيض فضلا عن بيان مجملها وتخصيص عامها
المسألة الثانية
يجوز من الله تعالى أن يسمع المكلف العام من غير أن يسمعه ما يخصصه وهو قول النظام وأبي هاشم والفقهاءوقال أبو الهذيل والجبائي لا يجوز ذلك في العام المخصوص بدليل السمع وإن جاز أن يسمعه المخصوص بأدلة العقل وأن لم يعلم السامع أن في العقل ما يدل على تخصيصه
لنا ثلاثة أوجه
الأولأن ذلك قد وقع كثيرا لأن كثيرا من الصحابة سمعوا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم مع أنهم لم يسمعوا قوله صلى الله عليه و سلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث وسمعوا قوله تعالى اقتلوا المشركين مع أنهم لم يسمعوا قوله صلى الله عليه و سلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب إلى زمان عمر رضي الله عنه
الثاني
أجمعنا على جواز خطابه بالعام المخصوص بالعقل من غير أن يخطر بباله ذلك المخصص فوجب أن يجوز خطابه بالعام المخصوص بالسمع من غير أن يسمعه ذلك المخصص والجامع كونه في الصورتين متمكنا من معرفة المراد
الثالث
أن الواحد منا كثيرا ما يسمع الألفاظ العامة المخصوصة قبل مخصصاتها وإنكاره مكابرة في الضرورياتاحتجوا بأمور
أحدهاأن إسماع العام دون إسماع المخصص إغراء بالجهل
وثانيها
أن العام لا يدل على مراد المخاطب بإسماعه وحدة كخطاب العربي بالزنجيةوثالثها
أن دلالة العام مشروطة بعدم المخصص فلو جازسماع العام دون سماع المخصص لما جاز الاستدلال بشيء من العمومات إلا بعد الطواف في الدنيا وسؤال كل علماء الوقت أنه هل وجد له مخصص وذلك يفضي إلى سقوط العمومات
والجواب عن الأول
أن الإغراء غير حاصل لما قدمنا من أنه يفيد ظن العموم لا القطع بهوبه خرج الجواب عن الثاني
وعن الثالث
أن كون اللفظ حقيقة في الاستغراق مجازا في غيره يفيد ظن الاستغراق والظن حجة في العمليات والله أعلم
الكلام في الأفعال
وفيه مسائلاختلفت الأمة في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على قولين
أحدهما
قول من ذهب إلى أنه لا يجوز أن يقع منهم ذنب صغيرا كان أو كبيرا لا عمدا ولا سهوا ولا من جهة التأويل وهو قول الشيعةوالآخر
قول من ذهب إلى جوازه عليهم ثم اختلفوا فيما يجوز من ذلك وما لا يجوزوالاختلاف في هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة
أحدها
ما يقع في باب الاعتقاد وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يقع منهم الكفروقالت الفضيلية من الخوارج إنه قد وقعت منهم ذنوب وكل ذنب عندهم كفر وشرك
وأجازت الشيعة إظهار الكفر على سبيل التقية
فأما الاعتقاد الخطأ الذي لا يبلغ الكفر مثل أن يعتقد مثلا أن الأعراض باقية ولا يكون كذلك فمنهم من أباه لكونه منفرا ومنهم من جوزه
وثانيها
باب التبليغ واتفقوا على أنه لا يجوز عليهم التغيير وإلا لزال الوثوق بقولهموقال قوم يجوز ذلك من جهة السهو
وثالثها
ما يتعلق بالفتوى واتفقوا أيضا على أنه لا يجوز عليهم الخطأ فيهوجوزه قوم على سبيل السهو
ورابعها مايتعلق بأفعالهم واختلفت الأمة فيه على أربعة أقوال
أحدهاقول من جوز عليهم الكبائر عمدا وهؤلاء منهم من قال بوقوع هذا الجائز وهم الحشوية
وقال القاضي أبو بكر هذا وإن جاز عقلا ولكن السمع منع من وقوعه
وثانيها
أنه لا يجوز أن يرتكبوا كبيرة ولا صغيرة عمدا لكن يجوز أن يأتوا بها على جهة التأويل وهو قول الجبائيوثالثها
أنه لا يجوز ذلك لا عمدا ولا من جهة التأويل لكن على سبيل السهو وهم مؤاخذون بما يقع منهم على هذه الجهة وإن كان موضوعا عن أمتهم لأن معرفتهم أقوى فيقدرون على التحفظ عما لا يتأتى لغيرهمورابعها
أنه لا يجوز أن يرتكبوا كبيرة وأنه قد وقعت منهم صغائر على جهة العمد والخطأ والتأويل إلا ما ينفركالكذب والتطفيف وهو قول أكثر المعتزلة
والذي نقول به أنه لم يقع منهم ذنب على سبيل القصد لا صغيرا ولا كبيرا
أما السهو فقد يقع منهم لكن بشرط أن يتذكروه في الحال وينبهوا غيرهم على أن ذلك كان سهوا
وقد سيقت هذه المسألة في علم الكلام ومن أراد الاستقصاء فعليه بكتابنا في عصمة الأنبياء والله أعلم
المسألة الثانية
اختلفوا في أن فعل الرسول صلى الله عليه و سلم بمجرده هل يدل على حكم في حقنا أم لا على أربعة أقوالأحدها
أنه للوجوب وهو قول ابن سريج وأبي سعيد الاصطخري وأبي علي بن خيران
وثانيها
أنه للندب ونسب ذلك إلى الشافعي رضي الله عنهوثالثها
أنه للإباحة وهو قول مالك رحمه اللهورابعها
يتوقف في الكل وهو قول الصيرفي وأكثر المعتزلة وهو المختارلنا
أنا إن جوزنا الذنب عليه جوزنا في ذلك الفعل أن يكون ذنبا له ولنا وحينئذ لا يجوز لنا فعله
وإن لم نجوز الذنب عليه جوزنا كونه مباحا ومندوبا وواجبا وبتقدير أن يكون واجبا جوزنا أن يكون ذلك من خواصه وأن لا يكون
ومع احتمال هذه الأقسام امتنع الجزم بواحد منها
واحتج القائلون بالوجوب بالقرآن والإجماع والمعقول
أما القرآن فسبع آياتإحداها
قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره والأمر حقيقة في الفعل على ما تقدم بيانه والتحذير عن مخالفة فعله يقتضي وجوب موافقة فعلهوثانيتها
قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وهذا مجراه مجرى الوعيد فيمن ترك التأسي به ولا معنى للتأسي به إلا أن يفعل الإنسان مثل فعله
وثالثتها
قوله تعالى واتبعوه وظاهر الأمر للوجوب والمتابعة هي الإتيان بمثل فعلهورابعتها
قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني دلت الآية على أن محبةالله مستلزمة للمتابعة لكن المحبة واجبة بالإجماع ولازم الواجب واجب فمتابعته واجبة
وخامستها
قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه فإذا فعل فقد آتانا بالفعل فوجب علينا أن نأخذهوسادستها
قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دلت الآية بإطلاقها على وجوب طاعة الرسول والآتي بمثل فعل الغير أجل أن ذلك الغير فعله طائع لذلك الغير فوجب أن يكون ذلك واجباوسابعتها
أن قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بين أنه تعالى إنما زوجه بها ليكون حكم أمته مساويا لحكمه في ذلك وهذا هو المطلوب
وأما الإجماع فلأن الصحابة رضي الله عنهم بأجمعهم اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين فقالت عائشة رضي الله عنها فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه
وسلم فاغتسلنا فرجعوا إلى ذلك وإجماعهم على الرجوع حجة وهو المطلوب
وإنما كان لفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد أجمعوا ها هنا على أن مجرد الفعل للوجوب ولأنهم واصلوا الصيام لما واصل وخلعوا
نعالهم في الصلاة لما خلع وأمرهم عام الحديبية بالتحلل بالحلق فتوقفوا فشكا إلى أم سلمة
فقالت أخرج إليهم واحلق واذبح ففعل فذبحوا وحلقوا متسارعين
ولأنه خلع خاتمه فخلعوا ولأن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبلك لما قبلتك
وأنه عليه الصلاة و السلام قال في جواب من سأل أم سلمة عن قبلة الصائم ألاأخبرته أنني أقبل وأنا صائم
وأما المعقول فمن وجهين
الأول
أن الاحتياط يقتضي حمل الشيء على أعظم مراتبه وأعظم مراتب فعل الرسول صلى الله عليه و سلم أن يكون واجبا عليه وعلى أمته فوجب حمله عليه
بيان الأول أن الاحتياط يتضمن دفع ضرر الخوف عن النفس بالكلية ودفع الضرر عن النفس واجب
بيان
الثاني
أن أعظم مراتب الفعل أن يكون واجبا على الكلالثاني
أنه لا نزاع في وجوب تعظيم الرسول صلى الله عليه و سلم في الجملة وإيجاب الإتيان بمثل فعله تعظيم له بدليل العرف والتعظيمان يشتركان في قدر من المناسبة فيجمع بينهما بالقدر المشترك فيكون ورود الشرع بإيجاب ذلك التعظيم يقتضي وروده بأن يجب على الأمة الإتيان بمثل فعله
والجواب عن الأول
لا نسلم أن لفظ الأمر حقيقة في الفعل على ما تقدمسلمناه لكنه بالإجماع أيضا حقيقة في القول فليس حمله على ذلك بأولى من حمله على هذا
سلمناه لكن ها هنا ما يمنع من حمله على الفعل وهو من وجهين
الأول
أن تقدم ذكر الدعاء وذكر المخالفة يمنع منه فإن الإنسان إذا قال لعبده لا تجعل دعائي كدعاء غيري واحذر مخالفة أمري فهم منه أنه أراد بالأمر القولالثاني
وهو أنه قد أريد به القول بالإجماع فلا يجوز حمله على الفعل لأن اللفظ المشترك لا يجوز حمله على معنييه
سلمناه لكن الهاء راجعة إلى الله تعالى لأنه أقرب المذكورين
فإن قلت القصد هو الحث على اتباع الرسول صلى الله عليه و سلم لأنه تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فحث بذلك على الرجوع إلى أقواله وأفعاله ثم عقب ذلك بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره فعلمنا أنه بعث بذلك على التزام ما كان دعا إليه من الرجوع إلى أمر النبي عليه الصلاة و السلام
وأيضا
فلم لا يجوز الحكم بصرف الكناية إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه و سلمقلت الجواب عن الأول
أن صرف هذا الضمير إلى الله تعالى مؤكد لهذا الغرض أيضا لأنه لما حث على الرجوع إلى أقوال الرسول وأفعاله ثمحذر عن مخالفة أمر الله تعالى كان ذلك تأكيدا لما هو المقصود من متابعة الرسول صلى الله عليه و سلم
وعن الثاني
أن الهاء كناية عن واحد فلا يجوز عوده إلى الله تعالى والى الرسول معاسلمنا عود الضمير إلى الرسول فلم قلت إن عدم الإتيان بمثل فعله مخالفة لفعله
فإن قلت يدل عليه أمران
الأول
أن المخالفة ضد الموافقة لكن موافقة فعل الغير هو أن تفعل مثل فعله فمخالفته هو أن لا تفعل مثل فعله
الثاني
وهو أن المعقول من المختلفين هما اللذان لا يقوم أحدهما مقام الآخر والعدم والوجود لا يقوم أحدهما مقام الآخر بوجه أصلا فكانا في غاية المخالفةفثبت أن عدم الإتيان بمثل فعله مخالف للإتيان بمثل فعله من كل الوجوه
قلت هب أنها في أصل الوضع كذلك لكنها في عرف الشرع ليست كذلك ولهذا لا يسمى إخلال الحائض بالصلاة مخالفة للمسلمين بل هي عبارة عن عدم الإتيان بمثل فعله إذا كان الإتيان به واجبا وعلى هذا لا يسمى ترك مثل فعل النبي صلى الله عليه و سلم مخالفة إلا إذا دل فعله على الوجوب
فإذا أثبتنا ذلك بهذا الدليل لزم الدور وهو محال
والواجب عن الثاني
لم قلت إن الإتيان بمثل فعل الغير مطلقا يكون تأسيا به بل عندنا كما يشترط في التأسي المساواة في الصورة يشترط فيه المساواة في الكيفية حتى إنه لو صام واجبا فتطوعنا بالصوم لم نكن متأسين به وعلى هذا لا يكون مطلق فعل الرسول عليه الصلاة و السلام سببا للوجوب في حقنا لأن فعله قد لا يكون واجبا فيكون فعلنا إياه على سبيل الوجوب قادحا في التأسي وتمام الأسئلة سيأتي في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى
والجواب عن الثالث
أن قوله واتبعوه إما أن لا يفيد العموم أو يفيدهفإن كان
الأول
سقط التمسك بهوإن كان الثاني فبتقدير أن يكون ذلك الفعل واجبا عليه وعلينا وجب أن نعتقد فيه أيضا هذا الاعتقاد والحكم بالوجوب يناقضه فوجب أن لا يتحقق
وهذا هوالجواب عن التمسك بقوله تعالى فاتبعوني
والجواب عن الخامس
لا نسلم أن قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه يتناول الفعل ويدل عليه وجهانالأول
أن قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا يدل على أنه عنى بقوله ما آتاكم ماأمركم
الثاني
أن الإتيان إنما يتأتى في القول لأنا نحفظه وبامتثاله يصير كأننا أخذناه فيصير كأنه صلى الله عليه و سلم أعطاناهوالجواب عن السادس
أن الطاعة هي الإتيان بالمأمور أو بالمراد على اختلاف المذهبين فلم قلت إن مجرد فعل الرسول صلى الله عليه و سلم يدلعلى أنا أمرنا بمثله أو أريد منا مثله وهذا هو أول المسألة
والجواب عن الإجماع من وجوه
الأولأن هذه أخبار آحاد فلا تفيد العلم
ولهم أن يقولوا هب أنها تفيد الظن لكن لما حصل ظن كونه دليلا ترتب عليه ظن ثبوت الحكم فيكون العمل به دافعا لضرر مظنون فيكون واجبا
وتقرير هذه الطريقة سيجيء إن شاء الله تعالى في مسألة القياس
الثاني
أن أكثر هذه الأخبار واردة في الصلاة والحج فلعله صلى الله عليه و سلم كان قد بين لهم أن شرعه وشرعهم سواء في هذه الأمور قال صلى الله عليه و سلم صلوا كما رأيتموني أصلي وعليه خرج مسألة التقاء الختانين وقال خذوا عني مناسككم وعليه خرج تقبيل عمر للحجر الأسود
وقال هذا وضوئي ووضوء الآنبياء من قبلي
وأما الوصال فإنهم ظنوا لما أمرهم بالصوم واشتغل معهم به أنه قصد بفعله بيان الواجب ففعلوا فرد عليهم ظنهم وأنكر عليهم الموافقة
وأما خلع النعل فلا نعلم أنهم فعلوا ذلك واجبا
وأيضا لا يمتنع أن يكونوا لما رأوه قد خلع نعله مع تقدم قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ظنوا
أن خلعها مأموربه غير مباح لأنه لو كان مباحا لما ترك به المسنون في الصلاة
على أنه صلى الله عليه و سلم قال لهم لم خلعتم نعالكم فقالوا لأنك خلعت نعلك فقال إن جبريل أخبرني أن فيها أذى فبين بهذا أنه ينبغي أن يعرفوا الوجه الذي أوقع عليه فعله ثم يتبعونه
وأما خلع الخاتم فهو مباح فلما خلع أحبوا موافقته لا لاعتقادهم وجوب ذلك عليهم
والجواب عن الوجه الأول من المعقول
أن الاحتياط إنما يصار إليه إذا خلا عن الضرر قطعا وها هنا ليس كذلك لاحتمال أن يكون ذلك الفعل حراما على الأمة وإذا احتمل الأمران لم يكن المصير إلى الوجوب احتياطاوعن الثاني
إن ترك الإتيان بمثل ما يأتي به الملك العظيم قد يكون تعظيما ولذلكيقبح من العبد أن يفعل كل ما يفعل سيده
واحتج القائلون بالندب بالقرآن والإجماع والمعقول
أما القرآن فقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولو كان التأسي واجبا لقال عليكم فلما قال لكم دل على عدم الوجوب ولما أثبت الأسوة الحسنة دل على رجحان جانب الفعل على جانب الترك فلم يكن مباحاوأما الإجماع فهو أنا رأينا أهل الأعصار متطابقين على الاقتداء في الأفعال بالنبي صلى الله عليه و سلم وذلك يدل على انعقاد الإجماع على أنه يفيد الندب
وأما المعقول فهو أن فعله عليه الصلاة و السلام إما أن يكون راجح العدم أو مساوى العدم أو مرجوح العدم والأول باطل لما ثبت أنه لا يوجد منه الذنب
والثاني باطل ظاهرا لأن الاشتغال به عبث والعبث مزجور عنه بقوله تعالى
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فتعين الثالث وهو أن يكون مرجوح العدم ثم إنا لما تأملنا أفعاله وجدنا بعضها مندوبا وبعضها واجبا والقدر المشترك هو رجحان جانب الوجود وعدم الوجوب ثابت بمقتضى الأصل فأثبتنا الرجحان مع عدم الوجوب
والجواب عن الأول
ما تقدم أن التأسي في إيقاع الفعل على الوجه الذي أوقعه عليهفلوا كان فعله واجبا أو مباحا وفعلناه مندوبا لما حصل التأسي
وعن الثاني
أنا لا نسلم أنهم استدلوا بمجرد الفعل فلعلهم وجدوا مع الفعل قرائن أخرىوعن الثالث
لا نسلم أن فعل المباح عبث لأن العبث هو الخالي عن الغرض فإذا حصلت في المباح منفعة ما لم يكن عبثا بل من حيث حصول النفع به خرج عن العبث فلم قلتم بأنه خلا عن الغرض ثم حصول الغرض في التأسي بالنبي صلى الله عليه و سلم ومتابعته في أفعاله بين فلا يعد من أقسام العبث والله أعلم
واحتج القائلون بالإباحة
بأنه لما ثبت أنه لا يجوز صدور الذنب منه ثبت أن فعله لا بد أن يكون إما مباحا أو مندوبا أو واجباوهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل
فأما رجحان جانب الفعل فلم يثبت على وجوده دليل لأن الكلام فيه وثبت على عدمه لأن دليل هذا الرجحان كان معدوما والأصل في كل شيء بقاؤه على ما كان فثبت بهذا أنه لا حرج في فعله قطعا ولا رجحان في فعله ظاهرا
فهذا الدليل يقتضي في كل أفعاله أن يكون مباحا ترك العمل به في الأفعال التي علم كونها واجبة أو مندوبة فيبقى معمولا به في الباقي
وإذا ثبت كونه مباحا ظاهرا وجب أن يكون في حقنا كذلك للآية الدالة على وجوب التأسي ترك العمل به فيما كان من خواصه فيبقى معمولا به في الباقي
والجواب
هب أنه في حقه كذلك فلم يجب أن يكون في حق غيره كذلك والله أعلمالمسألة الثالثة
قال جماهير الفقهاء والمعتزلة التأسي به واجب ومعناه أنا إذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه و سلم فعل فعلا على وجه الوجوب فقد تعبدنا أن نفعله على وجه الوجوب وإن علمنا أنه تنفل به كنا متعبدين بالتنفل به وإن علمنا أنه فعله على وجه الإباحة كنا متعبدين باعتقاد إباحته لنا وجاز لنا أن نفعله
وقال أبو علي بن خلاد من المعتزلة نحن متعبدون بالتأسي به في العبادات دون غيرها كالمناكحات والمعاملات
ومن الناس من أنكر ذلك في الكل
واحتج أبو الحسين بالقرآن والإجماع
أما القرآن فقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والتأسي بالغير في أفعاله هو أن يفعل على الوجه الذي فعل ذلك الغير ولم يفرق الله تعالى بين أفعال الرسول صلى الله عليه و سلم إذا كانت مباحة أو لم تكن مباحةوقوله تعالى واتبعوه أمر بالاتباع فيجب و أما الإجماع فهو أن السلف رجعوا إلى أزواجه
في قبلة الصائم وفي أن من أصبح جنبا لم يفسد صومه وفي تزوج النبي صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو حرام وذلك يدل على أن
أفعاله لا بد من أن يمتثل فيها طريقه
ولقائل أن يقول على الدليل الأول الآية تقتضي التأسي به مرة واحدة كما أن قول القائل لغيره لك في الدار ثوب حسن يفيد ثوبا واحدا
فإن قلت هذا إن ثبت تم غرضنا من التعبد بالتأسي به صلى الله عليه و سلم في الجملة
وأيضا فالآية تفيد إطلاق كون النبي صلى الله عليه و سلم أسوة حسنة لنا ولا يطلق وصف الإنسان بأنه أسوة حسنة إذا لم يجز لزيد لزيد أن يتبعه إلا في فعل واحد وإنما يطلق ذلك إذا كان ذلك الإنسان قدوة لزيد يقتدي به في
الأمور كلها إلا ما خصه الدليل
قلت الجواب عن الأول
أن أحدا لا ينازع في التأسي به صلى الله عليه و سلم في الجملة لأنه لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي و خذوا عني مناسككم فقد أجمعوا على وقوع التأسي به ها هنا والآية ما دلت إلا على المرة الواحدة فكان التأسي به صلى الله عليه و سلم في هذه الصورة كافيا في العمل بالآية لا سيما والآية إنما وردت على صيغة الاخبار عما مضى وذلك يكفي فيه وقوع التأسي به فيما مضىوالجواب عن الثاني
أنك إن أردت به أنه لا يصح إطلاق اسم الأسوةعليه إلا إذا كان أسوة في كل شيءفهذا ممنوع ثم الذي يدل على فساده وجهان
الأول
أن من تعلم من إنسان نوعا واحدا من العلم يقال له إن لك في فلان أسوة حسنةالثاني
وهو أن يقال لك في فلان أسوة حسنة في كل شيء ويقال لك من فلان أسوة حسنة في هذا الشيء دون ذاك ولو اقتضى اللفظ العموم لكان الأول تكريرا والثاني نقضاوإن أردت أنه يصح إطلاق اسم الأسوة إذا كان أسوة في بعض الأشياء فهذا مسلم ولكنه صلى الله عليه و سلم عندنا أسوة لنا في أقواله وفي كثير من أفعاله التي أمرنا بالاقتداء به فيها كقوله صلى الله عليه و سلم صلوا
كما رأيتموني أصلي و خذوا عني مناسككم
والجواب عن الحجة الثانية
ان قوله تعالى واتبعوه مطلق في الاتباع فلا يفيد العموم في كل شيء من الاتباعات والأمر لا يقتضي التكرار فلا يفيد العموم في كل الأزمنةفإن قلت ترتيب الحكم على الاسم يشعر بأن المسمى علة لذلك الحكم فماهية المتابعة علة للأمر بها
قلت فعلى هذا لو قال السيد لعبده اسقني يلزم أن يكون أمرا له بجميع أنواع السقي في كل الأزمنة ولو
قال له قم يلزم أن يكون أمرا له بجميع أنواع القيام في كل الأزمنة
وفي هذه الأمثلة كثرة وما ذكرناه كاف في إفساد ما قالوا والله أعلم
وأما الإجماع فقد سبق الكلام عليه والله أعلم
القسم الثاني في التفريع على وجوب التأسي
المسألة الأولىلما عرفت أن التأسي مطابقة فعل المتأسى به على الوجه الذي وقع فعله عليه وجب معرفة الوجه الذي يقع عليه فعل الرسول صلى الله عليه و سلم وهو ثلاثة الإباحة و الندب و الوجوب
أما الإباحة فتعرف بطرق أربعة
أحدها
أن ينص الرسول صلى الله عليه و سلم على أنه مباح
وثانيها
أن يقع امتثالا لآية دالة على الإباحةوثالثها
أن يقع بيانا لآية دالة على الإباحةورابعها
أنه لما ثبت أنه لا يذنب ثبت أنه لا حرج عليه في ذلك الفعل ولا في تركهوانتفى الوجوب والندب بالبقاء على الأصل فحينئذ يعرف كونه مباحا
وأماالندب فيعرف بتلك الثلاثة الأول مع أربعة أخرى
أحدها
أن يعلم من قصده صلى الله عليه و سلم أنه قصد القربة بذلك الفعل فيعلم أنه راجح الوجود ثم نعرف انتقاءالوجوب بحكم الاستصحاب فيثبت الندبوثانيها
أن ينص على أنه كان مخيرا بين ما فعل وبين فعل ما ثبت أنه ندب لأن التخيير لا يقع بين الندب وبين ما ليس بندبوثالثها
أن يقع قضاء لعبادة كانت مندوبةورابعها
أن يداوم على الفعل ثم يخل به من غير نسخ فتكون إدامته عليه الصلاة و السلام دليلا على كونه طاعة وإخلاله به من غير نسخ دليلا على عدم الوجوبوأما الوجوب فيعرف بتلك الثلاثة ألأول مع خمسة أخرى
أحدها
الدلالة على أنه كان مخيرا بينه وبين فعل آخر قد ثبت وجوبه لأن التخيير لا يقع بين الواجب وبين مال ليس بواجبوثانيها
أن يكون قضاء لعبادة قد ثبت وجوبهاوثالثها
أن يكون وقوعه مع أمارة قد تقرر في الشريعة أنها أمارة الوجوب كالصلاة بأذان وإقامة
ورابعها
أن يكون جزاء لشرط فوجب كفعل ما وجب بالنذروخامسها
أن يكون لو لم يكن واجبا لم يجز كالجمع بين ركوعين في صلاة الكسوفالمسألة الثانية
في الفعل إذا عارضه معارض منه ص فهو إما أن يكون قولا أو فعلا
أما القول فإما أن يعلم أن المتقدم هو القول أو الفعل أو لا يعلم واحد منهما
أما
القسم الأول وهو أن يكون المتقدم هو القول فالفعل المعارض له إما أن يحصل
عقيبه أو متراخيا عنهفإن كان متعقبا فإما أن يكون القول متناولا له خاصة أو لأمته خاصة أوله ولهم معا
لا يجوز أن يتناوله خاصة إلا على قول من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقته وإن تناول أمته خاصة وجب المصير إلى القول دون الفعل وإلا كان القول لغوا ولا يلغو الفعل لأن حكمه ثابت في الرسول صلى الله عليه و سلم
وإن كان الخطاب يعمه وإياهم دل فعله على أنه مخصوص من القول وأمته داخلة فيه لا محالة
وإن كان الفعل متراخيا عن القول فإن كان القول عاما لنا وله صار مقتضاه منسوخا عنا وعنه
وإن تناوله دونه كان نسخا عنا دونه لأن القول لم يتناوله وإن تناوله دوننا كان منسوخا عنه دوننا ثم يلزمنا مثل فعله لوجوب التأسي به
القسم الثاني
أن يكون المتقدم هو الفعل فالقول المعارض له إما أن يحصل عقيبه أو متراخيا عنهفإن كان متعقبا فإما أن يكون القول متناولا له خاصة أو لأمته خاصة أو عاما فيه وفيهم
فإن كان متناولا له خاصة وقد كان الفعل المتقدم دالا على لزوم مثله لكل مكلف في المستقبل فيصير ذلك القول المختص به مخصصا له عن ذلك العموم
وإن كان متناولا لأمته خاصة دل على أن حكم الفعل مختص به دون أمته
وإن كان عاما فيه وفيهم دل على سقوط حكم الفعل عنه وعنهم
وأما إن كان القول متراخيا عن الفعل فإن كان متناولا له ولأمته فيكون القول ناسخا لحكم الفعل عنه وعن أمته
وإن كان يتناول أمته دونه فيكون منسوخا عنهم دونه
وإن كان يتناوله دون أمته فيكون منسوخا عنه دون أمته
القسم الثالث
إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر فها هنا يقدم القول على الفعل ويدل عليه وجهانالأول
أن القول أقوى من الفعل والأقوى راجحوإنما قلنا إن القول أقوى لأن دلالة القول
تستغني عن الفعل ودلالة الفعل لا تستغني عن القول والمستغنى أقوى من المحتاج
والثاني أنا نقطع بأن القول قد تناولنا وأما الفعل فبتقدير أن يتأخر كان
متناولا لنا وبتقدير أن يتقدم لا يتناولنا فكون القول متناولا لنا معلوم وكون الفعل متناولا لنا مشكوك والمعلوم مقدم على المشكوكفرع
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن استقبال
القبلة واستدبارها في قضاءالحاجة ثم جلس في البيوت لقضاء الحاجة مستقبل بيت المقدس
فعند الشافعي رضي الله عنه أن نهيه مخصوص بفعله في الصحراء حتى يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البيوت لكل أحد
وعند الكرخي رحمه الله يجب إجراء النهي على إطلاقه في الصحراء والبنيان فكان ذلك من خواص الرسول صلى الله عليه و سلم
وتوقف القاضي عبدالجبار في المسألة
حجة الشافعي رضي الله عنه أن النهي عام ومجموع الدليل الذي يوجب علينا أن
نفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة و السلام مع كونه مستقبل القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة أخص من ذلك النهي والخاص مقدم على العام فوجب القول بالتخصيص والله أعلم
أما إذا كان المعارض للفعل فعلا آخر فذلك على وجهين
الأول
أن يفعل الرسول صلى الله عليه و سلم فعلا يعلم بالدليل أن غيره مكلف به ثم نراه بعد ذلك قد أقر بعض الناس على فعل ضده فنعلم أنه خارج منهالثاني
إذا علمنا أن ذلك الفعل إنما يلزم أمثاله الرسول صلى الله عليه و سلم في مثل تلك الأوقات ما لم يرد دليلناسخ لم يفعل عليه الصلاة و السلام ضده في مثل ذلك الوقت فنعلم أنه كان قد نسخ عنه
تنبيه
التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحقا ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره وأنه لازم له في مستقبل الأوقاتوإنما يقال إن ذلك الفعل قد لحقه النسخ بمعنى أنه قد زال التعبد بمثله وأن التخصيص قد لحقه على معنى أن بعض المكلفين لا يلزمه مثله والله أعلم
القسم الثالث في
أن الرسول صلى الله عليه و سلم هل كان متعبدا بشرع من قبلهوفيه بحثان
البحث الأولأنه قبل النبوة هل كان متعبدا بشرع من قبله أثبته قوم ونفاه آخرون وتوقف فيه ثالث
احتج المنكرون بأمرين
الأولأنه لو كان متعبدا بشرع أحد لوجب عليه الرجوع إلى علماء تلك الشريعة والاستفتاء منهم والأخذ بقولهم ولو كان
كذلك لاشتهر ولنقل بالتواتر قياسا على سائر أحواله فحيث لم ينقل علمنا أنه ما كان متعبدا بشرعهم
الثاني
أنه لو كان على ملة قوم لافتخر به أولئك القوم ولنسبوه إلى أنفسهم ولاشتهر ذلكفإن قلت ولو لم يكن متعبدا بشرع أحد لاشتهر ذلك قلت الفرق أن قومه ما كانوا على شرع أحد فبقاؤه لا على شرع البتة لا يكون شيئا بخلاف العادة فلا تتوفر الدواعي على نقله
أما كونه على شرع لما كان بخلاف عادة قومة فوجب أن ينقل
احتج المثبتون بأمرين
الأولأن دعوة من تقدمه كانت عامة فوجب دخوله فيها
الثاني
أنه كان يركب البهيمة ويأكل اللحم ويطوف بالبيتوالجواب عن الأول
أنا لا نسلم عموم دعوة من تقدمهسلمناه لكن لا نسلم وصول تلك الدعوة إليه بطريق
وجيب العلم أو الظن الغالب وهذا هو المراد من زمان الفترة
وعن الثاني أن نقول
أما ركوب البهائم فهو حسن في العقل إذا كان طريقا إلى حفظها بالعلف وغيرهوأما أكله لحم المذكى فحسن أيضا لأنه ليس فيه مضرة على حيوان
وأما طوافه بالبيت فبتقدير ثبوته لا يجب لو فعله من غير شرع أن يكون حراما
البحث الثاني
في حاله عليه السلام بعد النبوةقال جمهور المعتزلة وكثير من الفقهاء إنه لم يكن متعبدا بشرع أحد
وقال قوم من الفقهاء بل كان متعبدا بذلك إلا ما استثناه الدليل الناسخ ثم اختلفوا فقال قوم كان متعبدا بشرع إبراهيم وقيل بشرع موسى وقيل بشرع عيسى
واعلم أن من قال إنه كان متعبدا بشرع من قبله إما أن يريد به أن الله تعالى كان يوحي إليه بمثل تلك الأحكام التي أمر بها من قبله
أو يريد أن الله تعالى أمره باقتباس الأحكام من كتبهم
فإن قالوا بالأول فإما أن يقولوا به في كل شرعه
أو في بعضه والأول معلوم البطلان بالضرورة لأن شرعنا يخالف شرع من قبلنا في كثير من الأمور
والثاني مسلم ولكن ذلك لا يقتضي إطلاق القول بأنه كان متعبدا بشرع غيره
لأن ذلك يوهم التبعية وأنه صلى الله عليه و سلم ما كان تبعا لغيره بل كان أصلا في شرعهوأما الاحتمال الثاني وهو حقيقة المسألة فيدل على بطلانه وجوه
الأول
لو كان متعبدا بشرع أحد لوجب أن يرجع في أحكام الحوادث إلى شرعه وأن لا يتوقف إلى نزول الوحي لكنه لم يفعل ذلك لوجهين
الأول أنه لو فعل لاشتهر
والثاني أن عمر رضي الله عنه طالع ورقة من التوراة فغضب رسول الله عليه الصلاة و السلام وقال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي ولما لم يكن كذلك علمنا أنه لم يكن متعبدا بشرع أحدفإن قيل الملازمة ممنوعة لاحتمال أن يقال إنه صلى الله عليه و سلم علم في تلك الصور أنه غير متعبد فيها بشرع من قبله فلا جرم توقف فيها على نزول الوحي
أو لأنه عليه ا لصلاة والسلام علم خلو شرعهم عن حكم تلك الوقائع فانتظر الوحي
أو لأن احكام تلك الشرائع إن كانت منقولة بالتواتر فلا يحتاج في معرفتها إلى الرجوع إليهم وإلى كتبهم
وإن كانت منقولة بالآحاد لم يجز قبولها لأن أولئك الرواة كانوا كفارا ورواية الكافر غير مقبولة
سلمنا الملازمة لكن قد ثبت رجوعه إلى التوراة في الرجم لما احتكم إليه اليهود
والجواب
قوله إنما لم يرجع إليها لأنه عليه الصلاة و السلام علم أنه غير متعبد فيها بشرع من قبلهقلنا فلما لم يرجع في شيء من الوقائع إليهم وجب أن يكون ذلك لأنه علم أنه غير متعبد في شيء منها بشرع من قبله
قوله إنما لم يرجع إليها لعلمه بخلو كتبهم عن تلك الوقائع قلنا العلم بخلو كتبهم عنها لا يحصل إلا بالطلب الشديد والبحث الكثير فكان يجب أن يقع منه ذلك البحث والطلب
قوله ذلك الحكم إما أن يكون منقولا بالتواتر أو بالآحاد
قلنا يجوز أن يكون متن الدليل متواترا إلا أنه لا بد في العلم بدلالته على المطلوب من نظر كثير وبحث دقيق فكان يجب اشتغال النبي عليه الصلاة و السلام بالنظر في كتبهم والبحث عن كيفية دلالتها على الأحكام
قوله إنه رجع في الرجم إلى التوراة
قلنا لم يكن رجوعه إليها رجوع مثبت للشرع بها والدليل عليه أمور
أحدها
أنه لم يرجع إليها في غير الرجموثانيها
أن التوراة محرفة عنده فكيف يعتمد عليهاوثالثها
أن من أخبره بوجود الرجم في التوراة لم يكن ممن يقع العلم بخبرهفثبت أن رجوعه إليها كان ليقرر عليهم أن ذلك الحكم كما أنه ثابت في شرعه فهو أيضا ثابت في شرعهم وأنهم
أنكروه كذبا وعنادا
الحجة الثانية
أنه عليه السلام لو كان متعبدا بشرع من قبله لوجب على علماء الأعصار أن يرجعوا في الوقائع إلى شرع من قبله ضرورة أن التأسي به واجب وحيث لم يفعلوا ذلك البتة عمنا بطلان ذلكالحجة الثالثة
أنه عليه الصلاة و السلام صوب معاذا في حكمه باجتهاد نفسه إذا عدم حكم الحادثة في الكتاب والسنة ولو كان متعبدا بحكم التوراة كما تعبد بحكم الكتاب لم يكن له العمل باجتهاد نفسه حتى ينظر في التوراة والإنجيل
فإن قلت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يصوب معاذا في العمل بالاجتهاد إلا إذا عدمه في الكتاب والتوراة كتاب و لأنه لم يذكر التوراة لأن في القرآن آيات دالة على الرجوع إليها كما أنه لم يذكر الإجماع لهذا السبب
قلت الجواب عن الأول من وجهين
الأول أنه لا يفهم من إطلاق الكتاب إلا القرآن فلا يحمل على غيره إلا بدليلالثاني أنه لم يعهد من معاذ قط تعلم التوراة والإنجيل والعناية بتميز المحرف منها عن غيره كما عهد منه تعلم القرآن وبه ظهر الجواب عن الثاني
الحجة الرابعة
لو كانت تلك الكتب حجة علينا لكان حفظها من فروض الكفايات كما في القرآن والأخبار ولرجعوا إليها في مواضع اختلافهم حيث أشكل عليهم كمسألة العول وميراث الجد والمفوضة وبيع أم الولد وحد الشرب والربا في غير النسيئة وديةالجنين والرد بالعيب بعد الوطء والتقاء الختانين وغير ذلك من الأحكامولما لم ينقل عن واحد منهم مع طول أعمارهم وكثرة وقائعهم واختلافاتهم مراجعة التوراة لا سيما وقد أسلم من أحبارهم من تقوم الحجة بقولهم كعبدالله بن
سلام وكعب ووهب وغيرهم ولا يجوز القياس إلا بعد اليأس من الكتاب وكيف يحصل اليأس قبل العلم دل على أنه ليس بحجة
احتجوا بأمور
أحدهاقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون
وثانيها
قوله تعالى فبهداهم اقتده أمره أن يقتدي بهموثالثها
قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده
ورابعها
قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاوخامسها
قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاوالجواب عن الأول
أن قوله يحكم بها النبيون لا يمكن إجراؤه على ظاهره لأن جميع النبيين لم يحكموا بجميع ما في التوراة وذلك معلوم بالضرورة فوجب إما تخصيص الحكم وهو أن كل النبيين حكموا ببعضه وذلك لا يضرنا
فإن نبينا حكم بما فيه من معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله
أو تخصيص النبيين وهو أن النبيين حكموا بكل ما فيه وذلك لا يضرنا
وعن الثاني
أنه تعالى أمر بأن يقتدى بهدي مضاف إلى كلهم وهداهمالذي اتفقوا عليه هو الأصول دون ما وقع فيه النسخ
وعن الثالث
أنه يقتضي تشبيه الوحي بالوحي لا تشبيه الموحى به بالموحى بهوعن الرابع
أن الملة محمولة على الأصول دون الفروع ويدل عليه أمورأحدها
أنه يقال ملة الشافعي وأبي حنيفة واحدة وإن كان مذهبهمافي كثير من الشرعيات مختلفا
وثانيها
قوله بعد هذه الآية وما كان من المشركينوثالثها
أن شريعة ابراهيم عليه السلام قد اندرستوعن الخامس
أن الآية تقتضي أنه وصى محمدا عليه الصلاة و السلام بالذي وصى به نوحا عليه السلام من أن يقيسوا الدين ولا يتفرقوا فيه وأمرهم بإقامة الدين لا يدل على اتفاق دينهما كما أن أمر الإثنين أن يقوما بحقوق الله تعالى لا يدل على أن الحق على أحدهما مثل الحق على الآخر وعلى أن الآية تدل على أنه تعبد محمدا بما وصى به نوحا عليهما السلام والله أعلم
الكلام في الناسخ والمنسوخ وهو مرتب على أقسام
القسم الأول في حقيقة النسخ وفيه مسائل
المسألة الأولى
النسخ في أصل اللغة بمعنى إبطال الشيء وقال القفال إنهللنقل والتحويل
لنا
إنه يقال نسخت الريح آثار القوم إذا أعدمتها و نسخت الشمس الظل إذا أعدمته لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر فيظن أنه انتقل إليه والأصل في الكلام الحقيقة وإذا ثبت كون اللفظ حقيقة في الإبطال وجب أن لا يكون حقيقة في النقل دفعا للاشتراكفإن قيل وصفهم الريح بأنها ناسخة للآثار والشمس بأنها ناسخة للظل مجاز لأن المزيل للآثار والظل هو
الله تعالى وإذا كان ذلك مجازا امتنع الاستدلال به على كون اللفظ حقيقة في مدلوله
ثم نعارض ما ذكرتموه ونقول بل النسخ هو النقل والتحويل
ومنه نسخ الكتاب إلى كتاب آخر كأنك تنقله إليه أو تنقل حكايته
ومنه تناسخ وتناسخ القرون قرنا بعد قرن
وتناسخ المواريث إنما هو التحويل من واحد إلى آخر بدلا عن الأول فوجب أن يكون اللفظ حقيقة في النقل ويلزم أن لا يكون حقيقة في الإزالة دفعا للاشتراك وعليكم الترجيح
والجواب عن الأول من وجهين
أحدهماأنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى هو الناسخ لذلك من حيث فعل الشمس والريح المؤثرين في تلك الإزالة ويكونان أيضا ناسخين لكونهما مختصين بذلك التأثير
وثانيهما
أن أهل اللغة إنما أخطأوا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح فهب أنه كذلك لكن متمسكنا إطلاقهم لفظ النسخ على الإزالة لا إسنادهم هذا الفعل إلى الريح والشمس
وعن الثاني
أن النقل أخص من الزوال لأنه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصلت صفة أخرى فإذن مطلق العدم أعم من عدم يحصل عقيبه شيء آخر وإذا دار اللفظ بين العام والخاص كان جعله حقيقة في العام أولى من جعله حقيقة في خاص على ما تقدم تقريره في كتاب الغات والله أعلمالمسألة الثانية
في حد النسخ في اصطلاح العلماءالذي ذكره القاضي أبو بكر وارتضاه الغزالي رحمهما الله أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه
وإنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملا ل للفظ و الفحوى و المفهوم وكل دليل اذ يجوز النسخ بجميع ذلك
وإنما قلنا على ارتفاع الحكم الثابت ليتناول الأمر والنهي والخبر وجميع أنواع الحكم
وإنما قلنا بالخطاب المتقدم لأن ابتداء ايجاب العبادات في الشرع يزيل حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمى نسخا لأنه لم يزل حكم الخطاب
وإنما قلنا لولاه لكان ثابتا لأن حقيقة النسخ الرفع وهو إنما يكون رافعا إذا كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي
وإنما قلنا مع تراخيه عنه لأنه لو اتصل به لكان بيانا ل مدة هذه العبادة لا نسخا
ولقائل أن يقول هذا الحد مختل من وجوه
أحدها
أن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم المتقدم ناسخ للحكم الأول وليس بنسخ إذ النسخ هو نفس الارتفاع وفرق بين الرافع وبين نفس الارتفاع فجعل الرافع عين الارتفاع خطأوثانيها
أن تقييد ذلك بالخطاب خطأ لأن الناسخ قد يكون فعلا لا قولا فإنه صلى الله عليه و سلم إذا فعل فعلا وعلمنا بالضرورة أنه قصد به رفع بعض ما كان ثابتا فذلك يكون ناسخا مع أنه ليس بخطاب
فإن قلت الناسخ في الحقيقة هو الخطاب الدال على وجوب متابعته عليه السلام في أفعاله
قلت لو قدرنا أنه لم يرد أمر زائد يدل على وجوب متابعته في أفعاله ثم إنه عليه الصلاة و السلام فعل فعلا ووجد هناك من القرائن ما أفاد العلم الضروري بأن غرضه عليه الصلاة و السلام ازالة الحكم الذي كان ثابتا فإنه يكون ناسخا بالاجماع مع أنه لم يوجد الخطاب في هذه الصورة أصلا
وثالثها
أن الأمة إذا اختلفت على قولين فسوغت للعامي تقليد كل واحدة من الطائفتين ثم أجمعت بعد ذلك على أحد القولين فهذا الاجماع خطاب و هو ناسخ لجواز الأخذ بكلا القولين فقد وجد ها هنا خطاب دال على ارتفاع حكم خطاب مع أن الحق أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به
ويمكن جوابه بأنا ذكرنا حد النسخ مطلقا لا حد النسخ الجائز في الشرع
ورابعها
أن كون النسخ رفعا باطل وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالىوخامسها
أن قوله بالخطاب المتقدم خطأ لأن الحكم الأول لو ثبت بفعل النبي صلى الله عليه و سلم لا بقوله ل كان الذي يرفعه ناسخا له
فهذا ما في هذا الحد
والأولى أن يقال النسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاه ل كان ثابتا
فقولنا طريق شرعي نعني به القدر المشترك بين القول الصادر عن الله تعالى و عن رسوله عليه الصلاة و السلام و الفعل المنقول عنهما
ويخرج عنه اتفاق الأمة على أحد القولين لأن ذلك ليس بطريق شرعي على هذا التفسير
ولا يلزم أن يكون الشرع ناسخا لحكم العقل لأن العقل ليس بطريق شرعي
ولا يلزم أن يكون العجز ناسخا لحكم شرعي لأن العجز ليس بطريق شرعي
ولا يلزم تقييد الحكم بغاية أو شرط أو استثناء لأن ذلك غير متراخ
ولا يلزم ما إذا أمر نا الله تعالى بفعل واحد ثم نهانا عن مثله لأنه لو لم يكن هذا النهي لم يكن مثل حكم الأمر ثابتا
المسألة الثالثة
قال القاضي أبو بكر رحمه الله النسخ رفع ومعناه أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل بحيث لولا طريان الناسخ لبقي الا أنه زال لطريان الناسخ وقال الأستاذ أبو اسحاق رحمه الله إنه بيان ومعناه أن الخطاب الأول انتهى بذاته في ذلك الوقت ثم حصل بعده حكم آخر
والمثال الكاشف عن حقيقة هذه المسألة أن من قال ببقاء الأعراض قال الضد الباقي يبقى لولا طريان الطاريء ثم إن الطاريء يكون مزيلا لذلك الباقي
ومن قال بأنها لا تبقى قال الضد الأول ينتهي بذاته ويحصل ضده بعد ذلك من غير أن يكون للضد الطاريء أثر في ازالة ما قبله لأن الزائل بذاته لا يحتاج الى مزيل
واذا ظهر هذا التمثيل عادت الدلائل المذكورة في تلك المسألة الى هذه المسألة نفيا واثباتا فنقول
احتج المنكرون للرفع بوجوه
الحجة الأولىأنه ليس زوال الباقي بطريان الطاريء أولى من اندفاع الطاريء لأجل بقاء الباقي فإما أن يوجدا معا وهو محال بالضرورة أو بعد ما معا وهو محال لأن علة عدم كل واحد منهما وجود الآخر فلو عد ما معا لوجدا معا وذلك محال
فإن قلت لم لا يجوز أن يقال الحادث أقوى من الباقي لحدوثه
قلت هذا باطل لوجهين
أحدهما
أن الباقي إما أن يحصل له أمر زائد على ما كان حاصلا له حال حدوثه أو لا يحصلفإن كان الأول كان ذلك الزائد حادثا فذلك الزائد لحدوثه يكون مساويا للضد الطاريء في القوة
واذا استويا في القوة امتنع رجحان أحدهما على الآخر واذا امتنع عدم كيفية الباقي امتنع عدم ذلك الباقي لا محالة
وإن كان الثاني وهو أن لا يحصل للباقي أمر زائد على ما كان حاصلا له حال الحدوث لزم أن تكون قوة الباقي مساوية لقوة الحادث وحينئذ يبطل الرجحان
وثانيهما
أن الشيء حال حدوثه كما يمتنع عدمه فالباقي حال بقائه لا بد له من سبب لكونه ممكنا وهو مع السبب يمتنع عدمه فإذا امتنع العدم عليهما استويا في القوة فيمتنع الرجحانالحجة الثانية هي
أن طريا الحكم الطارىء مشروط بزوال المتقدم فلو كان زوال المتقدم معللا بطريان الطارىء لزوم الدور وهو محالالحجة الثالثة
أن الطارىء إما أن يطرأ حال كون الحكم الأول معدوما أو موجودافإن كان الأول استحال أن يؤثر في عدمه لأن إعدام المعدوم محال
وإن كان الثاني فقد وجد مع وجود الأول وإذا وجدا معا لم يكن بينهما منافاة وإذا لم يمكن بينهما منافاة لم يكن أحدهما رافعا للآخر
فإن قلت لم لا يجوز أن يكون ذلك كالكسر مع الانكسار قلت الانكسار عبارة عن زوال تلك التأليفات عن اجزاء ذلك الجسم والتأليفات أعراض غير باقية فلا يكون للكسر أثر في إزالتها
الحجة الرابعة هي
أن كلام الله تعالى قديم والقديم لا يجوز رفعه فإن قلت المرفوع تعلق الخطابقلت الخطاب إما أن يكون أمرا ثبوتيا أو لا يكون
فإن لم يكن أمرا ثبوتيا استحال رفعه وإزالته
وإن كان أمرا ثبوتيا فهو إما أن يكون حادثا أو قديما فإن كان حادثا لزم كونه تعالى محلا للحوادث
وإن كان قديما لزم عدم القديم وهو محال
واعلم أن هذه الوجوه كما أنها قوية في نفسها فهي أقوى لزوما على القاضي رحمه الله لأنه هو الذي عول عليها في امتناع إعدام الضد بالضد
والقول بكون النسخ رفعا عين القول بإعدام الضد بالضد فيكون لزوم هذه الأدلة عليه أقوى
واحتج إمام الحرمين رحمه الله على فساد الرفع
بوجه آخر وهو أن علم الله تعالى إما أن يكون متعلقا باستمرار هذا الحكم أبدا أو يكون متعلقا بأنه لا يبقى إلا إلى الوقت الفلاني فإن كان الأول استحال نسخه وإلا لزم انقلاب العلم جهلا وهو محال
والثاني يقتضي بطلان القول بالرفع لأن الله تعالى إذا علم أن ذلك الحكم لا يبقى إلا إلى ذالله الوقت استحال وجود ذلك الحكم بعذ ذلك وإلا لزم انقلاب العلم جهلا وإذا كان ممتنع الوجود بعد ذلك استحال أن يقع زواله بمزيل لأن الواجب لذاته يمتنع أن يكون واجبا لغيره
ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يقال علم الله تعالى أن ذلك الحكم لا يبقى إلى ذلك الوقت لطريان الناسخ
لا لذاته وإذا علم الله تعالى أنه يزول ذلك الحكم في ذلك الوقت لطريان ذلك الناسخ لم يكن ذلك قادحا في تعليل زواله بالنسخ
ويزيده تقريرا أن يقال إن الله تعالى كان يعلم أن العالم يوجد في الوقت الفلاني فيكون وجوده في ذلك الوقت واجبا ولم يكن ذلك الوجوب قادحا في افتقاره إلى المؤثر لإنه لما علم الله تعالى أنه يوجد في ذلك الوقت بذلك المؤثر لم يكن الوجوب على هذا الوجه قادحا في افتقاره إلى المؤثر فكذا ها هنا
واحتج القائلون بالرفع بأمرين
أولهماأن النسخ في اللغة عبارة عن الإزالة فوجب أن يكون في الشرع أيضا كذلك لأن الأصل عدم التغيير ولأننا ذكرنا في باب نفي الألفاظ الشرعية ما يدل على عدم التغيير
وثانيهما
أن الخطاب كان متعلقا بالفعل فذلك التعلق يمتنع أن يكون عدمه لذاته وإلا لزم أن لا يوجد وإن لم يكن لذاته فلا بد من مزيل ولا مزيل إلا الناسخوالجواب عن الأول
أنه تمسك بمجرد اللفظ وهو لا يعارض الدلائل العقلية
وعن الثاني
أن كلام الله تعالى القديم كان متعلقا من الأزل إلى الأبد باقتضاء الفعل إلى ذالله الوقت المعين والمشروط بالشيء عدم عند عدم الشرط فلا يفتقر زواله إلى مزيل آخر والله أعلمالمسألة الرابعة
النسخ عندنا جائز عقلا وواقع سمعا خلافا لليهود فإن منهم من أنكره عقلا ومنهم من جوزه عقلا لكنه منع منه سمعاويروى عن بعض المسلمين إنكار النسخ
لنا وجهان
الأولأن الدلالة القاطعة دلت على نبوة محمد عليه الصلاة و السلام ونبوته لا تصح إلا مع القول بنسخ شرع من قبله فوجب القطع بالنسخ
الثاني
أن الأمة مجمعة على وقوع النسخ
ولنا على اليهود إلزامان
الأولجاء في التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من الفلك إني قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه ثم قد حرم الله تعالى على موسى عليه السلام وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوانات
الثاني
كان آدم عليه السلام يزوج الأخ من الأخت وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلامولقائل أن يقول لا نسلم أن نبوة محمد عليه الصلاة و السلام لا تصح إلا مع القول بالنسخ لأن من الجائز أن يقال إن موسى
وعيسى عليهما السلام أمرا الناس بشرعهما إلى زمان ظهور شرع محمد عليه الصلاة و السلام ثم بعد ذلك أمر الناس باتباع شرع محمد عليه الصلاة و السلام فعند ظهور شرع محمد عليه الصلاة و السلام زال التكليف بشرع موسى وعيسى عليهما السلام ووقع التكليف بشرع محمد عليه السلام لكنه لا يكون نسخا بل يكون جاريا مجرى قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل
والمسلمون الذين أنكروا وقوع النسخ بنوا مذهبهم على هذا الحرف وقالوا قد ثبت في القرآن أن موسى وعيسى عليهما السلام بشرا في التوراة والإنجيل بمبعث محمد
ص -
وأنه عند ظهوره يجب الرجوع إلى شرعه وإذا كان الأمر كذلك امتنع تحقق
النسخ وهكذا جواب اليهود عن الإلزامين الذين أوردناهما عليهموأما ادعاء الإجماع فكيف يصح بعد ما صح وقوع الخلاف فيه
والمعتمد في المسألة قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وجه الاستدلال به أن جواز التمسك بالقرآن إما أن يتوقف على صحة النسخ أو لا يتوقف فإن توقف عاد الأمر إلى أن نبوة محمد صلى الله عليه و سلم لا تصح إلا مع القول بالنسخ وقد صحت نبوته فوجب القول بصحة النسخ
وإن لم نتوقف عليه فحييئذ يصح الاستدلال بهذه الآية على النسخ
واحتج منكرو النسخ عقلا بأن الفعل الواحد إما أن يكون حسنا أو قبيحا فإن
كان حسنا كان النهي عنه نهيا عن الحسن وإن كان قبيحا كان الأمر به أمرا بالقبيحوعلى كلا التقديرين يلزم إما الجهل وإما السفه
واحتج المنكرون شرعا بوجهين
ألأول هوأن الله تعالى لما بين شرع موسى عليه السلام فاللفظ الدال عليه إما أن يقال إنه دل على دوام شرعه أو ما دل عليه
فإن كان
الأول
فإما أن يكون قد ضم الله تعالى إليه ما يدل على أنه سينسخه أو لم يضم إليه ذلك فإن كان الأول فهو باطل من وجهينالأول
أن التنصيص على اللفظ الدال على الدوام مع التنصيص على أنه لا يدوم جمع بين كلامين متناقضين وإنه عبث وسفه
الثاني
أن يكون على هذا التقدير قد بين الله تعالى لموسى عليه السلام أن شرعه سيصير منسوخا فإذا نقل شرعه وجب أن ينقل هذه الكيفيةأما
أولا فلأنه لو جاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية جاز في شرعنا أيضا
ذلك وحينئذ لا يكون لنا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير منسوخوأما
ثانيا فلأن ذلك من الوقائع العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها وما كان
كذلك وجب اشتهاره وإلا فلعل القرآن عورض ولم ينقل ولعل محمدا عليه الصلاة و السلام غير هذا الشرع عن هذا الوضع ولم ينقلوإذا ثبت وجوب نقل هذه الكيفية بالتواتر وجب أن يكون العلم بتلك الكيفية كالعلم باصل الشرع حتى يكون علمنا بأن موسى عليه السلام نص على أن شرعه سيصير منسوخا كعلمنا بأصل شرعه ولو كان كذلك لعلم
الكل بالضرورة أن من دين موسى عليه السلام أن شرعه سيصير منسوخا ولو كان ذلك ضروريا لاستحال منازعة الجمع العظيم فيه وحيث نازعوا فيه دل ذلك على أنه عليه السلام ما نص على هذه الكيفية
وأما القسم الثاني وهو أن الله تعالى ذكر لفظا يدل على الدوام ولم يضم إليه ما يدل على أنه سيصير منسوخا فنقول على هذا التقدير وجب أن لا يصير منسوخا وإلا لزمت محالات
أحدها
أن ذكر اللفظ الدال على الدوام مع أنه لا دوام تلبيس وهو غير جائز
وثانيها
إن جوزنا ذلك لم يكن لنا طريق إلى العلم بأن شرعنا لا يصير منسوخا لأن أقصى ما في الباب أن يقول الشرع هذه الشريعة دائمة ولا تصير منسوخة قط البته ولكن إذا رأينا مثل هذا مع عدم الدوام في بعض الصور زال الوثوق عنه في كل الصوروثالثها
أنه مع تجويز مخالفة الظاهر لا يبقى وثوق بوعده ووعيده وكل بياناتهفإن قلت عرفناه بالإجماع أو بالتواتر
قلت أما الإجماع فلا يعرف كونه دليلا إلا بآية أو خبر ولا تتم دلالة الآية والخبر إلا بإجراء اللفظ على ظاهره فإذا جوزنا خلافه لا يبقى دليل الإجماع موثوقا به
وأما التواتر فكذلك لأن غايته أن نعلم أن الرسول عليه السلام قال هذه الألفاظ لكن لعله أراد شيئا يخالف ظواهرها
وأما القسم الثالث
وهو أن يقال إنه بين شرع موسى عليه السلام بلفظ لا يدل على الدوام البته فنقول مثل هذا لا يقتضي الفعل إلا مرة واحدة على ما ثبت أن الأمر لا يفيد التكرار ومثله لا يحتاج إلى النسخ بل لا يقبل النسخ البتهالثاني
قالوا ثبت بالتواتر أن موسى عليه السلام قال تمسكوابالسبت أبدا وقال تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض والتواتر حجة بالاتفاق
والجواب عن الأول أن نقول
لم لا يجوزأن يكون ذلك الفعل مصلحة في وقت ومفسدة في وقت آخر فيأمر به في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه وينهى عنه في الوقت الذي علم أنه مفسده فيهكما لا يمتنع أن يعلم فيما لا يزال أن إمراض زيد وفقره مصلحة له في وقت وصحته وغناه مصلحة له في وقت آخر فيمرضه ويفقره حين يعلم أن ذلك مصلحة يغنيه ويصحه حين يعلم أن ذلك مصلحة كما لا يمتنع أن يعلم الإنسان أن الرفق مصلحة ابنه وعبده اليوم والعنف مصلحته في غد فيأمر عبده بالرفق به في اليوم وبالعنف به في الغد
والجواب عن الثاني أن نقول
اتفق المسلمون على أنه تعالى بين شرع موسى عليه السلام بلفظ يدل على الدوام واختلفوا في أنه هل ذكر معه ما يدل على أنه سيصير منسوخا فقال أبو الحسين البصري رحمه الله يجب ذلك في الجملة وإلا كان تلبيسا
وقال جماهير أصحابنا وجماهير المعتزلة لا يجب ذلك وقد مر توجيه المذهبين في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب
ونحن نأتي بالجواب عن هذه الشبهة تفريعا على كل واحد من هذين المذهبين
أما على قول أبي الحسين من أنه لا بد من البيان فنقول لم لا يجوز أن يقال إنه تعالى بين في تلك الشريعة أنها ستصير منسوخة لكن لم ينقله أهل التواتر فلا جرم لم يشتهر ذلك كما اشتهر أصل الشرع
فإن قلت لما بين الله تعالى أصل ذلك الشرع وأوصله إلى أهل التواتر فهل أوصل ذلك المخصص إلى أهل التواتر أم لا
فإن قلت أوصله إلى أهل التواتر فإما أن يجوز على أهل التواتر أن يخلوا بنقله أو لا يجوز
فإن جاز على الشارع أن لا يوصل ذلك المخصص إلى أهل التواتر أو أنه أوصله إليهم لكنهم أخلوا بنقله جاز مثله في كل شرع فكيف تقطعون مع هذا التجويز بدوام شرعكم فلعلهاوإن كانت بحيث ستصير منسوخة إلا أن الله تعالى ما بين ذلك أو أن بينه لكن أهل التواتر أخلوا بنقله أيضا فلعل محمدا عليه الصلاة و السلام نسخ الصلوات الخمس وصوم رمضان ولم ينقل ذلك ولما بطل هذان الاحتمالان ثبت أنه تعالى بين ذلك المخصص
لأهل التواتر وأن أهل التواتر ما أخلوا بنقله وحينئذ يعود السؤال
قلت الإشكال إنما يلزم لو ثبت أنه حصل من اليهود في كل عصر ما بلغ مبلغ التواتر وذلك ممنوع فإنهم انقطعوا في زمان بخت نصر فلا جرم انقطعت الحجة بقولهم بخلاف شرعنا فإنهم كانوا في جميع الأعصار بالغين مبلغ التواتر
وأما الجواب
على قول أصحابنا رحمة الله عليهم فهو أن المخصص لم يكن مذكورا في زمان موسى عليه السلامقوله هذا تلبيس
قلنا سبق الجواب عنه في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب والله أعلم
والجواب عن الثالث
أنا لا نعلم أن موسى عليه السلام قال ذلك لأن نقل التوراة منقطع بحادث بخت نصرسلمنا صحة هذا النقل لكن لفظ التأبيد في التوراة قد جاء للمبالغة دون الدوام في صور
إحداها
قوله في العبد إنه يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة فإن أبى العتق فلتثقب أذنه ويستخدم أبداوثانيها
قيل في البقرة التي أمروا بذبحها يكون ذلك سنة أبدا ثم انقطع التعبد بذلك عندهم
وثالثها
أمروا في قصة دم الفصح بأن يذبحوا الجمل ويأكلوا لحمه ملهوجا ولا يكسروا منه عظما ويكون لهم هذا سنة ابدا ثم زال التعبد بذلكورابعها
قال في السفر الثاني قربوا إلي كل يوم خروفين خروفا غدوة وخروفا عشية قربانا دائما لاحقا بكمففي هذه الصور وجدت ألفاظ التأبيد ولم تدل على الدوام فكذا ما ذكرتموه والله أعلم
المسألة الخامسة
اتفقت الأمة على جواز نسخ القرآنوقال أبو مسلم بن بحر الأصفهاني لا يجوز
لنا وجوه
أحدهاأن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا وذلك في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ثم نسخ ذلك بأربعة
أشهر وعشر كما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
قال أبو مسلم الاعتداد بالحول ما زال بالكلية لأنها لو كانت حاملا ومدة حملها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملا وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصا لا نسخا
والجواب
أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل سواء حصل وضع الحمل لسنة أو أقل أو أكثر فجعل السنة مدة العدة يكون زائلا بالكليةوثانيها
أمر الله تعالى بتقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ثم نسخ ذلك
قال أبو مسلم إنما زال ذلك لزوال سببه لأن سبب التعبد بها أن يمتاز المنافقون من حيث لا يتصدقون عن المؤمنين فلما حصل هذا الغرض سقط التعبد بالصدقة
والجواب
لو كان كذلك لكان كل من لم يتصدق منافقا لكنه باطل لأنه روي أنه لم يتصدق غير علي بن أبي طالب رضي الله عنهويدل عليه أيضا قوله تعالى فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم
وثالثها
أن الله تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ثم نسخ ذلك بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين
ورابعها
قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها قال أبو مسلم النسخ هو الإزالة والمراد من هذه الآية ازالة القرآن من اللوح المحفوظ
والجواب
أن إزالة القرآن من اللوح المحفوظ لا تختص ببعض القرآن وهذا النص مختص ببعضهوخامسها
قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ثم أزالهم عنها بقوله فول وجهك شطر المسجد الحرام قال أبو مسلم حكم تلك القبلة ما زالبالكلية لجواز التوجه اليها عند الإشكال ومع العلم إذا كان هناك عدو
والجواب
أن على ما ذكرته أنت لا فرق بين بيت المقدس وسائر الجهات فالخصوصية التي لها امتاز بيت المقدس عن سائر الجهات قد بطلت بالكلية فيكون نسخاوسادسها
قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر والتبديل يشتمل على رفع وإثبات والمرفوع إما التلاوة وإما الحكم وكيف ما كان فهو رفع ونسخ
فإن قلت لم لا يجوز أن يكون المراد به أن الله تعالى أنزل أحدى الآيتين بدلا عن الأخرى فيكون النازل بدلا عما لم ينزل
قلت جعل المعدوم مبدلا غير جائز
واحتج أبو مسلم
بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا منخلفه فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل
وجوابه
المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله تعالى ما يبطله ولا يأتيه من بعده ما يبطله والله أعلمالمسألة السادسة
اختلفوا في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعلهمثاله إذا قال الله تعالى
لنا
صبيحة يومنا صلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارةثم قال عند الظهر لا تصللوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة فهذا عندنا جائز خلافا للمعتزلة وكثير من الفقهاءلنا
أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل عليهما السلام ثم نسخ ذلك قبل وقت الذبح
فإن قيل لا نسلم ان إبراهيم عليه السلام كان مأمورا بالذبح بل لعله كان مأمورا بمقدمات الذبح من الإضجاع وأخذ المدية مع الظن الغالب بكونه مأمورا بالذبح ولهذا قال قد صدقت الرؤيا ولو كان قد فعل بمعنى ما أمر به لكان قد صدق بعض الرؤيا
فإن قلت الدليل عليه ثلاثة أوجه
أحدها
قوله تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتافعل ما تؤمر فقوله ما تؤمر لا بد وأن يكون عائدا إلى شيء والمذكور ها هنا قوله إني أذبحك فوجب صرفه إليه
وثانيها
قوله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين ومقدمات الذبح لا توصف بأنها بلاء مبينوثالثها
قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم ولو لم يكن مأمورا بالذبح لما احتاج إلى الفداءقلت الجواب عن الأول
أن الرؤيا لا تدل على كونه مأمورا بذلك وأما قوله افعل ما تؤمرفإنما يفيد الأمر في المستقبل فلا ينصرف إلى ما مضى من رؤياه في المنام
وعن الثاني
أن إضجاع الابن وأخذ المدية مع غلبة الظن بأنه مأمور بالذبح بلاء مبينوعن الثالث
أنه إنما فدى بالذبح بسبب ما كان بتوقعه من الأمر بالذبحسلمنا أنه أمر بالذبح لكن لا نسلم أنه نسخ ذلك وبيانه من وجهين
الأول
أنه كلما قطع موضعا من الحلق وتعداه إلى غيره أوصل الله تعالى ما تقدم قطعهفإن قلت حقيقة الذبح قطع مكان مخصوص تبطل معه الحياة
قلت بطلان الحياة ليس جزءا من مسمى الذبح لأنه يقال قد ذبح هذا الحيوان وإن لم يمت بعد
الثاني
قيل إنه أمر بالذبح وإن الله تعالى جعل على عنقه صفيحة من حديد فكان إذا أمر ابراهيم عليه السلام السكين لم يقطع شيئا من الحلقسلمنا سلامة دليلكم لكنه معارض بدليل آخر وهو
أن ذلك يقتضي كون الشخص الواحد مأمورا منهيا عن فعل واحد في وقت واحد على وجه واحد وذلك محال فالمؤدي إليه محال
بيان أنه يلزم ذلك ثلاثة أوجه
أحدها
أن المسألة مفروضة في هذا الموضع فإنه لما أمر بكرة بركعتين من الصلاة عند غروب الشمس ثم نهى وقت الظهر عن ركعتين من الصلاة عند غروب الشمس فقد تعلق الأمر والنهي بشيء واحد في وقت واحد من وجه واحد حتى لو لم يتحقق شرط من هذه الشرائط لم تكن هي المسألة التي تنازعنا فيهاوثانيها
أن قوله صلوا عند غيبوبة الشمس غير موضوع إلا للأمر بالصلاة في ذلك الوقت لغة وشرعا
وقوله لا تصلوا عند غيبوبة الشمس غير موضوع إلا للنهي عن الصلاة في ذلك الوقت لغة وشرعا
وثالثها
هو أن النهي لو تعلق بغير ما تعلق به الأمر لكان لا يخلو إما أن يكون المنهي عنه أمرا يلزم من الانتهاء عنه وقوع الخلل في متعلق الأمر أو لا يلزم ذلكفإن كان الأول كان المتأخر رافعا المتقدم استلزاما فيلزم تواردالأمر والنهي على شيء واحد في وقت واحد من وجه واحد
وإن كان الثاني لم يكن ذلك هي المسألة التي تنازعنا فيها لأنا
توافقنا على أن الأمر بالشيء لا يمنع من النهي عن شيء آخر لا يلزم من الانتهاء عنه الإخلال بذلك المأمور
بيان أن ذلك محال أن ذلك الفعل في ذلك الوقت لا بد وأن يكون إما حسنا وإما قبيحا وكيفما كان فإما أن يقال المكلف ما كان عالما بحاله ثم بدا له ذلك فلذلك اختلف الأمر والنهي وذلك محال لاستحالة البداء على الله تعالى
وإما أن يقال أنه كان عالما بحاله فيلزم منه إما الأمر بالقبيح أو النهي عن الحسن وذلك أيضا محال
والجواب
الدليل على أنه كان مأمورا بالذبح أنه لو لم يكن مأمورا به بل كان مأمورا بمجرد المقدمات وهو قد أتى بتمامتلك المقدمات فوجب أن يحتاج معها إلى الفدية لأن الآتي بالمأمور به يجب خروجه عن العهدة والخارج عن العهدة لا يحتاج إلى الفداء فبحث وقعت الحاجة إليه علمنا أنه لم يدخل تمام المأمور به في الوجود
وهذا هو الجواب عن قوله
كلما قطع موضعا من الحلق وتعداه إلى غيره وصل الله تعالى ما تقدم قطعه لأن على هذا التقدير يكون كل المأمور به داخلا في الوجود فوجب أن لا يحتاج معه إلى الفداءوأما قوله تعالى قد صدقت الرؤيا فغير دال على أنه أتى بكل المأمور به بل يدل على انه عليه السلام صدقها وعزم على الإتيان بها فأما أنه فعلها بتمامها فليس في الآية دلالة عليه
قوله إن الله تعالى جعل على عنقه صفيحة من حديد
قلنا إن اعترفتم بأنه كان مأمورا بنفس الذبح لم يجز ذلك على قولكم وإلا فهو تكليف مالا يطاق
وإن قلتم إنه كان مأمورا بالمقدمات فهو عود إلى السؤال الأول
وأما المعارضة فالجواب عنها من وجهين
الأول وهو الذي يحسم المنازعة
أنها مبنية على القول بالحسن والقبح ونحن لا نقول بهالثاني
سلمنا ذلك ولكنا نقول كما يحسن الأمر بالشيء والنهي عن الشيء لحكمة تتولد من المامور به والمنهي عنه فقد يحسنان أيضا لحكمة تتولد من نفس الأمر والنهي فإن السيد قد يقول لعبده إذهب إلى القرية غدا راجلا ويكون غرضه من ذلك حصول الرياضة له في الحال وعزمه على أداء ذلك الفعل وتوطين النفس عليه مع علمه بأنه سيرفع عنه غدا ذلك التكليف
وإذا ثبت هذا فنقول ألأمر بالفعل إنما يحسن إذا كان المأمور به منشأ المصلحة والأمر به أيضا منشأ المصلحة
فأما إذا كان المأمور به منشأ المصلحة لكن الأمر به لا يكون منشأ المصلحة لم يكن الأمر به حسنا
وعند هذا يظهر الجواب عما قالوه لأنه حين أمر بالفعل كان المأمور به منشأ المصلحة وكان الأمر به أيضا منشأ المصلحة فلا جرم حسن الأمر به
وفي الوقت الثاني بقي المأمور به منشأ المصلحة لكن ما بقي الأمر به منشأ المصلحة فلا جرم حسن النهي عنه
فإن قلت لما بقي الفعل منشأ المصلحة كما كان فالنهي عنه يكون منعا عن منشأ المصلحة وذلك غير جائز
قلت إنه يكفي في المنع عن الشيء اشتماله على جهة واحدة من جهات المفسدة فها هنا المأمور به وإن بقي منشأ المصلحة إلا أن الأمر به والحث عليه لما صار منشأ المفسدة كان الأمر به وأن كان حسنا نظرا إلى المأمور به لكنه قبيح نظرا إلى نفس الأمر وذلك كاف في قبحه والله أعلم
المسألة السابعة
يجوز نسخ الشيء لا إلى بدل خلافا لقوملنا
أنه نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاةوالسلام لا إلى بدلاحتجوا بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
والجوابأن نسخ الآية يفيد نسخ لفظها ولهذا قال نأت بخير منها أو مثلها فليس لنسخ الحكم ذكر في الآية
سلمنا أن المراد نسخ الحكم لكن لم لا يجوز أن يقال إن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير من ثبوته في ذلك الوقت والله أعلم
المسألة الثامنة
يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه خلافا لبعض أهل الظاهرلنا
أن المسلمين سموا إزالة التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم نسخا وهو أشق وإزالة الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم نسخا وأمر الصحابة بترك القتال ثم أمرهم بنصب القتال مع التشديد بثبات الواحد للعشرة وحرم الخمر ونكاح المتعة بعد إطلاقهما ونسخ جواز تأخير الصلاة عند الخوف إلى إيجابها في أثناء القتال ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان وكانت الصلاة ركعتين عند قوم فنسخت بأربع في الحضراحتجوا بقوله تعالى نأت بخير منها
والخير ما هو أخف علينا
وبقوله تعالى يرد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
والجواب عن الأول
أن نقول بل الخير ما هو أكثر ثوابا وأصلح لنا
في المعاد وإن كان أثقل في الحال
وعن الثاني
أنه محمول على اليسر في الآخرة حتى لا يتطرق إليها تخصيصات غير محصورةالمسألة التاسعة
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس لأن التلاوة والحكم عبادتان منفصلتان وكل ما كان كذلك فإنه غير مستبعد في العقل أن يصيرا معا مفسدتين أو أن يصير أحدهما مفسدة دون الآخر وتكون الفائدة في بقاء التلاوة دون الحكم ما يحصل من العلم بأن الله تعالى أزال مثل هذا الحكم رحمة منه على عباده وقد نسخ الله تعالى الحكم دون التلاوة في قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
والتلاوة دون الحكم فيما يروى من قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله
وعن أنس رضي الله عنه إنه نزل في قتلى بئر معونة بلغوا إخواننا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا
وعن أبي بكر رضي الله عنه كنا نقرأ في القران لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم
والحكم والتلاوة معا وهو ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس
وروي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة
المسألة العاشرة
الخبر إما أن يكون خبرا عما لايجوز تغيره كقولنا العالم محدث وذلك لا يتطرق إليه النسخأو عما يجوز تغيره وهو إما أن يكون ماضيا أو مستقبلا والمستقبل إما أن يكون وعدا أو وعيدا أوخبرا عن حكم كالخبر عن وجوب الحج ويجوز النسخ في الكل
وقال أبو علي وأبو هاشم لا يجوز النسخ في شيء منه وهو قول أكثر المتقدمين
لنا
أن الخبر إذا كان عن أمر ماض كقوله عمرت نوحا ألف سنة جاز أن يبين من بعده أنه أراد ألف سنة إلا خمسين عاماوإن كان خبرا مستقبلا وكان وعدا أو وعيدا كقلوه لأعذبن الزاني أبدا فيجوز أن يبين من بعد أنه أراد ألف سنة
وإن كان خبرا عن حكم الفعل في المستقبل كان الخبر كالأمر في تناوله للأوقات المستقبلة فيصح إطلاق الكل
مع أن المراد بعض ما تناوله بموضوعه
فثبت أن حكم النسخ في الخبر كهو في الأمر
احتجوا بوجهين
الأولأن دخول النسخ في الخبر يوهم أنه كان كاذبا
والثاني
أنه لو جاز نسخ الخبر لجاز أن يقول أهلك الله عادا ثم يقول ما أهلكهم ومعلوم أنه لو قال ذلك كان كذباوالجواب عن الأول
أن دخول النسخ على الأمر يوهم البداء أيضا فإن قالوا لا يوهم لأن النهي إنما دل على أن الأمر لم يتناول ذلك الوقت
قلنا وها هنا أيضا لا يوهم الكذب لأن الناسخ يدل على أن الخبر ما تناول تلك الصورة
وعن الثاني
أن إهلاكهم غير متكرر لإنهم لا يهلكون إلا مرة واحدة فقطفقوله ما أهلكهم رفع لتلك المرة فيلزم الكذب
وأماإن أراد بقوله ما أهلكهم أنه ما أهلك بعضهم كان ذلك تخصيصا بالأشخاص لا بالأزمان فلم يكن نسخا والله أعلم
المسألة الحادية عشرة
إذا قال الله تعالى افعلوا هذا الفعل أبدا يجوز نسخه خلافا لقوملنا وجهان
الأولأن لفظ التأبيد في تناوله لجميع الأزمان المستقبلة كلفظ العموم في تناوله لجميع الأعيان فإذا جاز أحد التخصيصين فكذا
الثاني
والجامع هو الحكمة الداعية إلى جواز التخصيصالثاني
أن شرط النسخ أن يرد على ما أمر به على سبيل الدوام والتأبيد لا يدل إلا على الدوام فكان التأبيد شرطا لإمكان النسخ وشرط الشيء لا ينافيه
احتجوا بأمرين
الأولأن قوله أفعلوا أبدا قائم مقام قوله افعلوا في هذا الوقت وفي ذلك وذاك إلى أن يذكر الأوقات كلها ولو ذكر على هذا الوجه لم يجز النسخ فكذا إذا ذكر بلفظ التأبيد
الثاني
لو جاز نسخ ما ورد بلفظ التأبيد لم يكن لنا طريق إلى العلم بدوام التكليفوالجواب عن الأول
أن ذلك يمنع من النسخ كله لأن المنسوخ لا بد من كونه لفظا يفيد الدوام إما بصريحه وإما بمعناه ثم إنه ينتقض بأنه يجوز أن يقال جاءني الناس إلا زيدا ولا يجوز جائني زيد وعمر وبكر وما جاءني زيد
ثم الفرق ما حققناه في مسألة أن للعموم صيغة
وعن الثاني
أن لفظ التأبيد يفيد ظن الاستمرار لكن القطع به لا يحصل إلا من القرائن والله أعلم
القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
المسألة الأولىنسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه
الأول نسخ السنة المقطوعة بالسنة المقطوعة
والثانينسخ خبر الواحد بخبر الواحد كقوله عليه الصلاة و السلام
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها
وقال في شارب الخمر فإن شربها الرابعة فاقتلوه ثم حمل إليه من شربها الرابعة فلم يقتله
والثالث
نسخ خبر الواحد بالخبر المقطوع ولا شك فيهوالرابع
نسخ الخبر المتواتر وهو جائز في العقل غير واقع في السمع عند الأكثرين خلافا لبعض أهل الظاهرلنا
أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تترك خبر الواحد إذا رفع حكم الكتاب قال عمر رضي الله عنه لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبتوهذا الاستدلال ضعيف لأنا نقول هب أن هذا الحديث دل على أنهم ما قبلوا ذلك الخبر في نسخ المتواتر فكيف يدل على إجماعهم على أنهم ما قبلوا خبرا من أخبار الآحاد في نسخ المتواتر
واحتج اهل الظاهر بوجوه
الأولأنه جاز تخصيص المتواتر بالآحاد فجاز نسخه به والجامع دفع الضرر المظنون
الثاني
أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع فإذا صار معارضا لحكم المتواتر وجب تقديم المتأخر قياسا على سائر الأدلة
الثالث
أن نسخ الكتاب وقع بأخبار الآحاد من وجوه
احدها
قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية منسوخ بما روي بالآحاد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وثانيها قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكممنسوخ بما روي بالآحاد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
وثالثها
قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف منسوخ بما روي بالآحاد من قوله عليه الصلاة و السلام لا وصية لوارث
ورابعها
أن الجمع بين وضع الحمل والمدة منسوخ بأحد الأجلين وإذا ثبت نسخ الكتاب بخبر الواحد وجب جواز نسخ الخبر المتواتر لأنه لا قائل بالفرق
الرابع
أن أهل قبا قبلوا نسخ القبلة بخبر الواحد ولم ينكر الرسول عليه الصلاة و السلام ذلكالخامس
أنه عليه الصلاة و السلام كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ
والجواب عن الأول
أن الفرق بين النسخ والتخصيص واقع بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وللخصم أن يمنع وجود هذا الإجماع كما سبقوعن الثاني
أن المتواتر مقطوع في متنه والآحاد ليس كذلك فلم لا يجوز أن يكون هذا التفاوت مانعا من ترجيح خبر الواحدوأما الآيات فقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إنما يتناول الموحى إليه إلى تلك الغاية ولا يتناول ما بعد ذلك فلم يكن النهي الوارد بعده نسخا
وعن الثانية
أنا إنما خصصنا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بقوله عليه الصلاة و السلام لا تنكح المرأة على عمتها لتلقيالأمة هذا الحديث بالقبول وأيضا غير ممتنع أن يكون الخبر مقارنا فقبلوه مخصصا لا ناسخا
وعن الثالثة
أنه يجوز أن يصدر الإجماع عن خبر ثم لا ينقل ذلك الخبر أصلا استغناء بالإجماع عنه وإذا جاز ذلك فالأولى أن يجوز أن يصدر إجماعهم عن خبر ثم يضعف نقله استغناء بالإجماع عنهوإذا كان كذلك لم يمتنع ان يكون هذا الخبر مقطوعا به عندهم
ثم يضعف نقله لإجماعهم على العمل بموجبه
وهذا هو الجواب أيضا عن الرابعة
والجواب عن الحجة الرابعةلعل رسول الله عليه الصلاة و السلام أخبرهم بذلك قبل وقوع الواقعة فلهذا قبلوا خبر الواحد أو لعله انضم إليه من القرائن
ما أفاد العلم نحو كون المسجد قريبا من الرسول عليه الصلاة و السلام وارتفاع الضجة في ذلك
والجواب عن الحجة الخامسة
أنا سنبين ضعفها في باب خبر الواحد إن شاء الله تعالىالمسألة الثانية
قال الأكثرون يجوز نسخ الكتاب ودليله ما ذكرناه في الرد على أبي مسلم الأصفهانيبقي ها هنا أمران
احدهما
أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن وهو أيضا واقعوقال الشافعي رضي الله عنه لا يجوز
احتج المثبتون بأمور
أحدهاأن التوجه إلى بيت المقدس كان واجبا في الابتداء بالسنة لأنه ليس في القرآن ما يتوهم كونه دليللا عليه إلا قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله وذلك لا يدل عليه لأنها تقتضي التخيير بين الجهات
ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يقال التوجه إلى بيت المقدس وقع في الأصل بالكتاب إلا أنه نسخت تلاوته كما نسخ حكمه فإنه لا دليل يمنع من هذا التجويز
سلمنا أن التوجه إلى بيت المقدس وقع بالسنة فلم لا يجوز أن يقال وقع نسخه أيضا بالسنة وليس من حيث ثبت التوجه إلى الكعبة بالكتاب ما يوجب أن يكون التحويل عن بيت المقدس بالكتاب لأن الظاهر أنه حول عن بيت المقدس ثم
أمر بالتوجه إلى الكعبة ولهذا كان يقلب وجهه في السماء لا لوجه سوى أنه قد حول عن الجهة التي كان يتوجه إليها وينتظر ما يؤمر به من بعد فأمر بالتوجه إلى الكعبة فإن لم يكن ذلك هو الظاهر فهو مجوز وهذا كاف في المنع من من الاستدلال
وثانيها
قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وهو نسخ تحريم المباشرة وليس لتحريم في القرآنوثالثها
نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان وكان صوم عاشوراء ثابتا بالسنة
ورابعها
صلاة الخوف وردت في القرآن ناسخة لما ثبت بالسنة
من جواز تأخيرها إلى انجلاء القتال حتى قال عليه الصلاة و السلام يوم الخندق حشى الله قبورهم نارا لحبسهم عن الصلاة
وخامسها
قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار نسخ لما قرره رسول الله صلى الله عليه و سلم من العهد والصلحواعلم أن السؤالين المذكورين واردان في الكل
ومن الجهال من قدح في هذين السؤالين وقال لا حاجة بنا إلى تقدير سنة خافية مندرسة ولا ضرورة فلم نقدرهما
وهذا جهل عظيم لأن المستدل لا بد له من تصحيح مقدماته بالدلالة فإذا عجز عنها لم يتم دليله
واحتج الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم وهذا
يدل على أن كلامه بيان للقرآن والناسخ بيان للمنسوخ فلو كان القرآن ناسخا للسنة لكان القرآن بيانا للسنة فيلزم كون كل واحد منهما بيانا للآخروالجواب
ليس في قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم دليل على أنه لا يتكلم إلا بالبيان كما أنك إذا قلت إذا دخلت الدار لا أسلم على زيد ليس فيه أنك لا تفعل فعلا آخر
سلمنا أن السنة كلها بيان لكن البيان هو الإبلاغ وحمله على هذا أولى لأنه عام في كل القرآن أما حمله على بيان المراد فهو تخصيص ببعض ما أنزل وهو ما كان مجملا أو عاما مخصوصا وحمل اللفظ على ما يطابق الظاهر أولى من حمله على ما يوجب ترك الظاهر والله أعلم
المسألة الثالثة
نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقعوقال الشافعي رضي الله عنه لم يقع
احتج المثبتون بصور
أحداهاأنه كان الواجب على الزانية الحبس في البيوت لقوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بآية الجلد ثم إنه صلى الله عليه و سلم نسخ الجلد بالرجم
فإن قلت بل نسخ ذلك بما كان قرآنا وهو قوله الشيخ والشيخة إذ زنيا فارجموهما البته
قلت إن ذلك لم يكن قرآنا ويدل عليه أن عمر
رضي الله عنه قال لولا أن يقول الناس إن عمر زاد في كتاب الله شيئا لألحقت ذلك بالمصحف ولو كان ذلك قرآنا في الحال أو كان ثم نسخ لما قال ذلك
ولقائل أن يقول لما نسخ الله تعالى تلاوته وحكم بإخراجه من المصحف كفى ذلك في صحة قول عمر رضي الله عنه ولم يلزم منه القطع بأنه لم يكن البتة قرآنا
وثانيها
نسخ الوصية للأقربين بقوله عليه السلام لا وصية لوارث لأن آية المواريث لا تمنع الوصية إذ الجمع ممكن وهذا ضعيف لأن كون الميراث حقا للوارث يمنعه من صرفه إلى الوصية فثبت أن آية الميراث مانعة من الوصية ولأنقوله صلى الله عليه و سلم لا وصية لوارث خبر واحد إذ لو قلنا إنه كان متواترا لوجب أن يكون الآن متواترا لأنه خبر في واقعة مهمة تتوفر الدواعي على نقله وما كان كذلك وجب بقاؤه متواترا وحيث لم يبق الآن متواترا علمنا أنه ما كان متواترا في الأصل فالقول بأن الآية صارت منسوخة به يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز بالإجماع
واحتج الشافعي رضي الله عنه بأمور
الأولقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
والاستدلال من وجوه أربعة
أحدها
أنه تعالى أخبر أن ما ينسخه من الآيات يأت بخير منه وذلك يفيد أنه تعالى يأتي بما هو من جنسه كما إذا قال للإنسان ما أخذ منك من ثوب آتك بخير منه أنه يأتيه بثوب من جنسه خير منهوأذا ثبت أنه لا بد وأن يكون من جنسه فجنس القرآن قرآن
وثانيها
أن قوله تعالى نأت بخير منها يفيد أنه هو المتفرد بالإتيان بذلك الخير وذلك هو القرآن الذي هو كلام الله تعالى دون السنة التي يأتي بها الرسول عليه السلاموثالثها
أن قوله تعالى نأت بخير منها يفيد أن المأتي به خير من الآية والسنةلا تكون خيرا من القرآن
ورابعها
أنه تعالى قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير دل على أن الذي يأتي بخير منها هو المختص بالقدرة على إنزاله وهذا هو القرآن دون غيرهالثاني
قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم فوصفه بأنه مبين للقرآن ونسخ العبادة رفعها ورفعها ضد بيانهاالثالث
قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية أخبرتعالى بأنه هو الذي يبدل الآية بالآية
الرابع
أنه تعالى حكى عن المشركين أنهم قالوا عند تبديل الآية بالآية إنما أنت مفتر ثم إنه تعالى أزال هذا الإبهام بقوله قل نزله روح القدس من ربك وهذا يقتضي أن مالم ينزله روح القدس من ربه لا يكون مزيلا للإبهامالخامس
قوله تعالى قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وهذا يدل على أن القرآن لا تنسخه السنةالسادس
أن ذلك يوجب التهمة والنفرةوالجواب عن الوجوه
التي تمسكوا بها في الآية الأولى بوجه عام ثم بما يخص كل واحد من تلك الوجوهأما العام فهو أن قوله تعالى نأت بخير منها ليس فيه
أن ذلك الخير يجب أن يكون ناسخا بل لا يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئا مغايرا للناسخ يحصل بعد حصول النسخ والذي يدل على تحقق هذا الاحتمال أن هذه الآية صريحة في أن الإتيان بذلك الخير مرتب على نسخ الآية الأولى فلو كان نسخ تلك الآية مرتبا على الإتيان بذلك الخير لزم ترتب كل
واحد منهما على الآخر وهو دور
وأما الوجوه الخاصة
فالجواب عن الأوللا نسلم أن ذلك الخير لا بد وأن يكون من جنس الآية المنسوخة فليس تعلقهم بالمثال الذي ذكروه أولى من مثال آخر وهو أن يقول القائل من يلقني بحمد وثناءجميل ألقه بخير منه في أنه لا يقتضي أن الذي يلقاه به من جنس الحمد والثناء أو من قبيل المنحة والعطاء
وعن الثاني
وهو أن قوله نأت بخير منها يفيد أنه هو المتفرد بالإتيان بذلك الخير أن نقولالمراد بالإتيان شرع الحكم وإلزامه والسنة في ذلك كالقرآن في أن المثبت لهما هو الله تعالى
وعن الثالث
وهو قوله السنة لا تكون خيرا من القرآن أن نقول إذا كان المراد بالخير الأصلح في التكليف والأنفع في الثواب لم يمتنع أن يكون مضمون السنة خيرا من مضمون الآيةوعن الرابع
أن النسخ رفع الحكم سواء ظهر ذلك بالقرآن أو بالسنة وعلى التقديرين فالله تعالى هو المتفرد بهوالجواب عن الحجة الثانية
أن النسخ لا ينافي البيان لأنه تخصيص للحكم بالأزمانكما أن التخصيص تخصيص للحكم بالأعيان
والجواب عن الحجة الثالثة
أن الناسخ سواء كان قرآنا أو خبرا فالمبدل في الحقيقة هو الله تعالىوالجواب عن الحجة الرابعة
أن من يتهم الرسول عليه الصلاة و السلام فإنما يتهمه لأنه يشك في نبوته ومن تكن هذه حاله فالنبي عليه الصلاة و السلام مفتر عنده سواء نسخ الكتاب بالكتاب أو بالسنة والمزيل لهذه التهمة التمسك بمعجزاته
والجواب عن الحجة الخامسة
وهي قوله تعالى ائت بقرآن غير هذا أو بدلهأنه يدل على أنه عليه الصلاة و السلام لا ينسخ إلا بوحي ولا يدل على أن الوحي لا يكون إلا قرآنا
والجواب عن الحجة السادسة
أن النفرة زائلة بالدليل الدال على أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله أعلم
المسألة الرابعة
في كون الإجماع منسوخا وناسخاالإجماع إنما ينعقد دليلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة و السلام لأنه ما دام عليه الصلاة و السلام حيا لم ينعقد الإجماع من دونه لأنه صلى الله عليه و سلم سيد المؤمنين ومتى وجد قوله عليه الصلاة و السلام فلا عبرة بقول غيره فإذن الإجماع إنما ينعقد دليلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة و السلام
إذا ثبت هذا فنقول
لو انتسخ الإجماع لكان انتساخه إما بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس الكل باطل
أما بالكتاب والسنة فلأنه لا يخلو إما أن يقال إنهما كانا موجودين وقت انعقاد ذلك الإجماع أو ما كانا موجودين في ذلك الوقت
فإن كانا موجودين مع أن الأمة حكمت على خلافهما كانت الأمة مجمعة على الخطأ ذاهبة عن الحق وإنه غير جائز
وإن لم يكونا موجودين استحال حدوثهما بعد ذلك لاستحالة أن يحدث كتاب أو سنة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة و السلام
وأما بالإجماع فلأن انعقاد هذا الإجماع الثاني إما أن يكون لا عن دليل أو عن دليل فإن لم يكن عن دليل كان ذلك إجماعا على الخطأ وإنه غير جائز
وإن كان عن دليل عاد التقسيم الأول من أن يقال إن ذلك الدليل
إما أن يكون حال انعقاد الإجماع الأول أو حدث بعده وقد بينا فساد هذين القسمين
فإن قلت أليس أن الأمة إذا اختلفت على قولين فقد جوزت للعامي أن يأخذ بأيهما شاء ثم إذا اتفقت بعذ ذلك على أحدهما فقد منعت العامي من الأخذ بذلك القول الثاني فها هنا الإجماع الثاني ناسخ لحكم الإجماع الأول
قلت الأمة إنما جوزت للعامي الأخذ بأي القولين شاء بشرط أن لا يحصل الإجماع على أحد القولين فكان الإجماع الأول
مشروطا بهذا الشرط فإذا وجد الإجماع فقد زال شرط الإجماع الأول فانتفى الإجماع الأول لانتفاء شرطه لا لأن الثاني نسخه
وأما بالقياس فلأن شرط صحة القياس عدم الإجماع فإذا وجد الإجماع لم يكن القياس صحيحا فلم يجز نسخه به
وأما كون الإجماع ناسخا فقد جوزه عيسى بن أبان
والحق أنه لا يجوز
لنا
أن المنسوخ بالإجماع إما أن يكون نصا أو إجماعا أو قياساوالأول يقتضي وقوع الإجماع على خلاف النص وخلاف
النص خطأ والإجماع لا يكون خطأ
والثاني أيضا باطل لأن الإجماع المتأخر إما أن يقتضي أن الإجماع الأول
حين وقع وقع خطأ أو يقتضي أنه كان صوابا ولكن إلى هذه الغايةوالأول باطل لأن الإجماع لا يكون خطأ ولو جاز ذلك لما كان المنسوخ به أولى من الناسخ
وإن كان صوابا حين وقع ولكن كان مؤقتا فلا يخلو ذلك الإجماع المتقدم المفيد للحكم المؤقت من أن يكون مطلقا أو مؤقتا
فإن كان مطلقا استحال أن يفيد الحكم مؤقتا
وإن كان مؤقتا إلى غاية فذلك الإجماع ينتهي عند حصول تلك الغاية بنفسه فلا يكون الإجماع المتأخر رافعا له
والثالث باطل لأن هذه المسألة لا تتصور إلا إذا اقتضي القياس حكما ثم
أجمعوا على خلاف حكم ذلك القياس فحينئذ يزول حكم ذلك القياس بعد ثبوته لتراخي الإجماععنه وهذا محال لأن شرط صحة القياس عدم الإجماع فإذا وجد الإجماع فقد زال شرط صحة القياس وزوال الحكم لزوال شرطه لا يكون نسخا
المسألة الخامسة
في كون القياس منسوخا وناسخاأما كونه منسوخا فنقول نسخ القياس إما أن يكون في زمان حياة الرسول عليه الصلاة و السلام أو بعد وفاته
فإن كان حال حياته فلا يمتنع رفعه بالنص أو بالإجماع أو بالقياس
أما بالنص فبأن ينص الرسول عليه الصلاة و السلام في الفرع على خلاف الحكم الذي يقتضيه القياس بعد استقرار التعبد بالقياس
وأما بالإجماع فلأنه إذا اختلفت الأمة على قولين
قياسا ثم أجمعوا على أحد القولين كان إجماعهم على أحد القولين رافعا لحكم القياس الذي اقتضاه القول الآخر
وأما بالقياس فبأن ينص في صورة على خلاف ذلك الحكم ويجعله معللا بعلة موجودة في ذلك الفرع وتكون أمارة عليتها أقوى من أمارة علية الوصف للحكم الأول في الأصل الأول ويكون كل ذلك بعد استقرار التعبد بالقياس الأول
وأما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة و السلام فإنه يجوز نسخه في المعنى وإن كان ذلك لا يسمى نسخا في اللفظ
أما بالنص فكما إذا اجتهد إنسان في طلب النصوص ثم لم يظفر بشيء أصلا ثم اجتهد فحرم شيئا بقياس ثم ظفر بعذ ذلك بنص أو إجماع أو قياس أقوى من القياس الأول على خلافه
فإن قلنا كل مجتهد مصيب كان هذا الوجدان ناسخا لحكم القياس الأول لكنه لا يسمى ناسخا لأن القياس إنما يكون معمولا به بشرط أن لا يعارضه شيء من ذلك
وإن قلنا المصيب واحد لم يكن القياس الأول متعبدا به فلم يكن النص الذي وجده أخرا ناسخا لذلك القياس
وأما كون القياس ناسخا فهو إما أن ينسخ كتابا أو سنة أو اجماعا أو قياسا والأقسام الثلاثة الأول باطلة بالإجماع
وأما الرابع وهو كونه ناسخا لقياس آخر فقد تقدم القول فيه والله أعلم
المسألة السادسة
في كون الفحوى منسوخا وناسخاأما كونه منسوخا فقد اتفقوا على جواز نسخ الأصل والفحوى معا
وأما نسخ الأصل وحده فإنه يقتضي نسخ الفحوى لأن الفحوى تبع الأصل وإذا زال المتبوع زال التبع لا محالة
وأما نسخ الفحوى مع بقاء الأصل فاختيار أبي الحسين رحمه الله أنه لا يجوز قال لأن فحوى القول لا يرتفع مع بقاء الأصل إلا وينتقض الغرض لأنه إذا حرم علينا التأفيف على سبيل الإعظام للأبوين كانت إباحة ضربهما
نقضا للغرض
وأما كونه ناسخا فمتفق عليه لأن دلالته إن كانت لفظية فلا كلام
وإن كانت عقلية فهي يقينية فتقتضي النسخ لا محالة والله أعلم
القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك وفيه مسائل
المسألة الأولىاتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون نسخا للعبادات ولا زيادة صلاة على الصلوات
وإنما جعل أهل العراق زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخا لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين لأنه يجعل ما كان وسطى غير وسطى
فقيل لهم ينبغي أن تكون زياردة عبادة على آخر العبادات نسخا
لأنه يجعل العبادة الأخيرة غير أخيرة ولو كان عدد كل الواجبات قبل الزيادة عشرة فبعد الزيادة لا يبقى ذلك فيكون نسخا
أما الزيادة التي لا تكون كذلك فقد اختلفوا فيها فمذهب الشافعي رضي الله عنه أنها ليست نسخا وهو قول أبي علي وأبي هاشم
وقالت الحنفية إنها نسخ
ومنهم من فصل ونذكر فيه وجهين
أحدهما
أن النص إن أفاد من جهة دليل الخطاب أو الشرط خلاف ما أفادته الزيادة كانت الزيادة نسخا وإلا فلا
وثانيهما
قول القاضي عبدالجبار إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شديدا حتى صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استئنافه فإنه يكون نسخا نحو زيادة ركعة على ركعتينوإن كان المزيد عليه لو فعل على حد ما كان يفعل قبل الزيادة صح فعله واعتد به ولم يلزم استئناف فعله وإنما يلزم أن يضم إليه غيره لم يكن نسخا نحو زيادة التغريب على الجلد وزيادة عشرين على حد القذف
واعلم أن لأبي الحسين البصري رحمه الله طريقة في
هذه المسألة هي أحسن من كل ما قيل فيها فقال
النظر في هذه المسألة يتعلق بأمور ثلاثة
أحدها
أن الزيادة على النص هل تقتضي زوال أمر أم لاوالحق أنه يقتضيه لأن إثبات كل شيء لا أقل من أن يقتضي زوال عدمه الذي كان
وثانيها
أن هذه الإزالة هل تسمى نسخاوالحق أن الذي يزول بسبب هذه الزيادة إن كان حكما شرعيا وكانت الزيادة متراخية عنه سميت تلك الإزالة نسخا
وإن كان حكما عقليا وهو البراءة الأصلية لم تسم تلك الإزالة نسخا
وثالثها
أنه هل تجوز الزيادة علىالنص بخبر الواحد والقياس أم لا والحق أنه إن كان الزائل حكم العقل وهو البراءة الأصلية جاز ذلك إلا أن يمنع منه مانع خارجي كما لو قيل خبر الواحد لا يكون حجة فيما تعم به البلوى والقياس لا يكون حجة في الحدود والكفارات إلا أن هده الموانع لا تعلق لها بالنسخ من حيث هو نسخ
وأما إن كان الحكم الزائل شرعيا فلينظر في دليل الزيادة فإن كان بحيث يجوز أن يكون ناسخا لدليل الحكم الزائل جاز إثبات الزيادة وإلا فلا
فهذا حظ البحث الأصولي ولنحقق ذلك في المسائل الفقهية المفرعة على هذا الأصل وهي ثمانية
الحكم الأول
زيادة التغريب أو زيادة عشرين على جلد ثمانين لا يزيل إلا نفي وجوب ما زاد على الثمانين وهذا النفي غير معلوم بالشرع لأن إيجاب الثمانين قدر مشترك بين إيجاب الثمانين مع نفي الزائد وبين إيجابه مع ثبوت الزيادة وما به الاشتراك لا إشعار له بما به الامتياز فإيجاب الثمانين لا إشعار له البتة بالزائد لا نفيا ولا إثباتا إلا أن نفي الزيادة معلوم بالعقل فإن البراءة الأصلية معلومة بالعقل ولم ينقلنا عنه دليل شرعيوإذا كان ذلك حكما عقليا جاز قبول خبر الواحد والقياس فيه إلا أن يمنع مانع سوى النسخ
وأما كون الثمانين وحدها مجزية وكونها وحدها كمال الحد وتعليق رد الشهادة عليها فكل ذلك تابع لنفي وجوب الزيادة فلما كان ذلك النفي معلوما بالعقل
جاز قبول خبر الواحد والقياس فيه فكما أن الفروض لو كانت خمسا لتوقف على أدائها الخروج عن عهدة التكليف وقبول الشهادة فلو زيد فيها شيء آخر لتوقف الخروج عن عهدة التكليف وقبول الشهادة على أداء ذلك المجموع مع أنه يجوز إثباته بخبر الواحد والقياس فكذا ها هنا
أما لو قال الله تعالى الثمانون كمال الحد وعليها وحدها يتعلق رد الشهادة لم نقبل في الزيادة ها هنا خبر الواحد والقياس لأن نفي وجوب الزيادة ثبت بدليل شرعي متواتر
وأيضا لو كان إيجاب الثمانين يقتضي على سبيل المفهوم نفي الزائد وثبت أن مفهوم المتواتر لا يجوز نسخه بخبر الواحد والقياس لكنا لا نثبت ذلك بخبر الواحد والقياس
الحكم الثاني
تقييد الرقبة بالإيمانهو في معنى التخصيص لأنه يخرج عتق الكافرة من الخطاب فإن كان المقتضي لهذا التقييد خبر واحد أو قياسا وكان متراخيا لم يقبل لأن عموم الكتاب أجاز عتق الكافرة فتأخير حظر عتقها في الكفارة هو النسخ بعينه فلم يقبل فيه خبر واحد ولا قياس
وإن كانا متقارنين فهو تخصيص والتخصيص بخبر الواحد والقياس يجوز
الحكم الثالث
إذا قطعت يد السارق وإحدى رجليه ثم سرق فإباحة قطع رجله الأخرى رفع لحظر قطعها وذلك الحظر إنماثبت بالعقل فجاز رفعه بخبر الواحد والقياس ولم يسم نسخا
الحكم الرابع
إذا أمرنا الله تعالى بفعل أو قال هو واجب عليكم ثم خيرنا بين فعله وبين فعل آخر فهذا التخيير يكون نسخا لحظر ترك ما أوجبه علينا إلا أن حظر تركه كان معلوما بالبقاء على حكم العقل وذلك لأن قوله أوجبت عليكم هذا الفعل يقتضي أن للإخلال به تأثيرا في استحقاق الذم وهذا لا يمنع من أن يقوم مقامه واجب آخر وإنما نعلم أن غيره لا يقوم مقامه لأن الأصل أن غيره غير واجب ولو كان واجبا بالشرع لدل عليه دليل شرعي فصار علمنا بنفي وجوبه موقوفا على أن الأصل نفي وجوبه مع نفي دليل شرعي فالمثبت لوجوبه إنما رفع حكما عقليا فجاز أن يثبته بقياس أو خبر واحد
مثال ذلك أن يوجب الله تعالى علينا غسل الرجلين ثم يخيرنا بينه وبين المسح على الخفين وكذلك إذا خيرنا الله تعالى بين شيئين ثم أثبت معهما ثالثا
فأما إذا قال الله تعالى هذا الفعل واجب وحده أو قال لا يقوم غيره مقامه فإن إثبات بدل له
فيما بعد رافع لما علمناه بدليل شرعي لأن قوله هذا واجب وحده صريح في نفي وجوب غيره فالمثبت لغيره رافع لحكم شرعي فلم يجز كونه خبر واحد ولا قياسا
فأما قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فهو تخيير بين استشهاد رجلين أو رجل وامرأتين والحكم بالشاهد واليمين زيادة في التخيير
وقد بينا أن الزيادة في التخيير ليس بنسخ يمنع من قبول خبر الواحد والقياس فيه
ومن قال الحكم بالشاهد واليمين نسخ لهذه الآية يلزمه أن يكون الوضوء بالنبيذ نسخا لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا
الحكم الخامس
إذا كانت الصلاة ركعتين فقط فزيد عليها ركعة أخرى قبل التشهد فإن ذلك يكون ناسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين وذلك حكم شرعي معلوم بطريقة معلومة فلا يثبت بخبر واحد ولا قياس وليس ذلك نسخا للركعتين لأن النسخ لا يتناول الأفعال ولا هو نسخ لوجوبهما فإنه ثابت ولا هو نسخ لإجزائهما لأنهما مجزيتان وإنما كانتا مجزيتين من دون رفعة أخرى والآن لا يجزيان إلا مع ركعة أخرى وذلك تابع لوجوب ضم ركعة أخرى ووجوب ركعة أخرى ليس يرفع إلا نفي وجوبها ونفي وجوبها إنما حصل بالعقل فلم يمتنع من هذه الجهة إن يقبل فيه خبر الواحد والقياس
وإما إذا زيدت الركعة بعد التشهد وقبل التحلل فإنه يكون نسخا لوجوب التحلل بالتسليم أو يكون ناسخا لكونه ندبا وذلك حكم شرعي معلوم فلم يجز أن يقبل فيه خبر الواحد ولا القياس
فأما كونه ناسخا للركعتين أو لوجوبهما أو لإجزائهما فالقول فيه ما ذكرناه الآن
الحكم السادس
زيادة غسل عضو في الطهارة ليس بنسخ لإجزائها ولا لوجوبها وإنما هو رفع لنفي وجوب غسل ذلك العضو وذلك النفي معلوم بالعقل وكذا زيادة شرط آخر في الصلاة لا يقتضي نسخ وجوب الصلاة فأما كون الصلاة غير مجزية بعد زيادة الشرط الثاني فهو تابع لوجوب ذلك الشرط وإجزاؤها تابع وجوبه ونفي وجوبه لم يعلم بالشرع فكذلك لنفي ما يتبعه فجاز قبول خبر الواحد والقياس فيه
هذا إن لم نكن قد علمنا نفي وجوب هذه الأشياء من دين النبي عليه الصلاة و السلام باضطرار
فأما إن علمناه باضطرار فقد صار معلوما بالشرع مقطوعا به فلم يجز بخبر الواحد والقياس
الحكم السابع
قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فإنه يفيد كون أول الليل طرفا وغاية للصيام كما يفيده لو قال تعالى آخر الصيام وغايته الليل لأن لفظة إلى موضوعة للغاية فإيجاب الصوم إلى غيبوبة الشفق يخرج أوله عن أن يكون طرفا مع أن الخطاب يفيده وفي ذلك كونه حقيقة فلا يقبل فيه خبر واحد ولا قياس لأن نفي وجوب صوم أول الليل معلوم بدليل قاطع
أما لو قال صوموا النهار ثم جاء الخبر بإتمام الصوم إلى غيبوبة الشفق لم يكن ذلك نسخا لأن الخبر لم يثبت ما نفاه النص لأن النص لم يتعرض لليل وإنما نفينا الصوم بالليل لأن الأصل أن لا صوم وقامت الدلالة في النهار خاصة على وجوب الصوم فبقي الليل على حكم العقل
الحكم الثامن
لو قال الله تعالى صلوا إن كنتم متطهرين فإنه لا يمتنع أن يقبل خبر الواحد والقياس في إثبات شرط آخر للصلاة لأن إثبات بدل الشرط لا يخرجه عن أن يكون شرطا إذ لا يمتنع أن يكون للحكم شرطان وليس كذلك إثبات صوم جزء من الليل لأن ذلك يخرج أول الليل من أن يكون غاية
وأما نفي كون الشرط الآخر شرطا فلم يعلم إلا بالعقل فلم يكن رفعه رفعا لحكم شرعي والله أعلم
المسألة الثانية
لا شك في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط ولا شك في أن مالا تتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخه نسخا للعبادة كما لو قال أوجبت الصلاة والزكاة ثم قال نسخت الزكاة
أما الذي تتوقف صحة العبادة عليه فذلك قد يكون جزءا من ماهية العبادة وقد يكون خارجا عنها واختلفوا فيه
فقال الكرخي نقصان ما تتوقف العبادة عليه سواء كان جزءا أو خارجا لا يقتضي نسخ العبادة وهو المختار
وقال القاضي عبدالجبار نقصان الجزء يقتضي نسخ الباقي ونقصان الشرط المنفصل لا يقتضي نسخ الباقي
فنقول الدليل عليه أن نسخ أحد الجزأين لا يقتضي نسخ الجزء الآخر وذلك لأن الدليل المقتضي للكل كان متناولا للجزأين فخروج أحد الجزأين لا يقتضي خروج الجزء الآخر كسائر أدلة التخصيص
واحتجوا بأن نقصان الركعة من الصلاة يقتضي رفع وجوب تأخير التشهد ونفي
إجزائها من دون الركعة لأن قبل النسخ ما كان تجوز الصلاة من دون هذه الركعةوأيضا
إن كانت الركعة لما نسخت أوحبت علينا أن نخلي الصلاة منها فقد ارتفع إجزاء الصلاة إذا فعلناها مع الركعة المنسوخة وإجزاء الصلاة مع الركعة قد يكون حكما شرعيا فجاز أن يكون رفعه نسخا
والجواب
أن هذه احكام للركعة الباقية مغايرة لذاتها فكان نسخها مغايرا لنسخ تلك الذات وأما نقصان الشرط المنفصل من العبادة فلا يقتضي نسخ العبادة لأنهما عبادتان فإذا نسخ إحداهما لدليل مقصور عليها لم يجز نسخ الآخرى
فعلى هذا نسخ الوضوء لا يكون نسخا للصلاة بل نفي الإجزاء مع فقد الطهارة قد زال وذلك لأن الصلاة ما كانت تجزىء بلا طهارة فإذا نسخ وجوب الطهارة صارت مجزية وارتفع نفي إجزائها فإن أراد الإنسان بقوله إن نسخ الوضوء يقتضي نسخ الصلاة هذا المعنى فصحيح لكن الكلام موهم لأن إطلاق القول بأن الصلاة منسوخة هو أنه قد خرجت عن الوجوب أو عن أن تكون عبادة والله أعلم
القسم الرابع في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا
قديعلم ذلك باللفظ تارة وبغيره اخرىأما اللفظ فهو أن يوجد لفظ النسخ أما بأن يقول هذا منسوخ أو يقول ذاك ينسخ هذا
وأما غير اللفظ فهو أن يأتي بنقيض الحكم الأول أو بضده مع العلم بالتاريخ
مثال النقيض قوله تعالى الآن خفف الله عنكم فإنه نسخ لثبات الواحد للعشرة لأن التخفيف نفي للثقل المذكور
ومثال الضد التحويل من قبلة إلى أخرى لأن التوجه إلى الكعبة ضد التوجه إلى بيت المقدس
وأما التاريخ فقد يعلم باللفظ أو بغيره
أما اللفظ فكما إذا قال أحد الخبرين قبل الآخر
وأما غير اللفظ فعلى وجوه
أحدها
أن يقول هذا الخبر ورد سنة كذا وهذا في سنة كذاوثانيها
أن يعلق أحدهما على زمان معلوم التقدم والآخر بالعكسكما لو قال كان هذا في غزاة بدر والآخر في غزاة أحد وهذه الآية نزلت قبل الهجرة و الأخرى بعدها
وثالثها
أن يروي أحدهما رجل متقدم الصحبة لرسول الله صلى الله عليه و سلم ويروي الآخر رجل متأخر الصحبة وانقطعت صحبة الأول للرسول عليه السلام عند ابتداء الآخر بصحبته فهذا يقتضي أن يكون خبر الأول متقدماأما لو دامت صحبة المتقدم مع الرسول عليه الصلاة و السلام لم يصح هذا الاستدلال
ويتفرع على هذا الأصل مسائل
مسألة
قال القاضي عبدالجبار الصحابي إذا قال في أحد الخبرينالمتواترين إنه كان قبل الآخر قبل ذلك وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم كما تقبل شهادة الشاهدين في الإحصان الذي يترتب عليه الرجم وإن لم يقبل في إثبات الرجم وكما يقبل قول القابلة في الولد إنه من إحدى المرأتين وإن كان يترتب على ذلك ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش مع أن شهادة المرأة لا تقبل في ثبوت النسب
قال أبو الحسين رحمه الله هذا يقتضي الجواز العقلي في قبول خبر الواحد في تاريخ الناسخ ولا يقتضي وقوعه إلا إذا تبين أنه يلزم من ثبوت أحد الحكمين ثبوت الآخر
مسألة
اذا قال الصحابي كان هذا الحكم ثم نسخ كقولهم إن خبر الماء من الماء نسخ بخبر التقاء الختانين لم يكن ذلك حجة لأنه يجوز أن يكون قاله اجتهادا فلا يلزمنا
وعن الكرخي أن الراوي إذا عين الناسخ فقال هذا نسخ هذا جاز أن يكون قاله اجتهادا فلا يجب الرجوع اليه
وإن لم يعين الناسخ بل قال هذا منسوخ وجب قبوله
لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلق النسخ اطلاقا
وهذا ضعيف فلعله قاله لقوة ظنه في أن الأمر كذلك وإن كان قد أخطأ فيه والله أعلم بالصواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام في الاجماع
هو مرتب على سبعة اقسام
القسم الأول في اصل الاجماع
المسألة الأولىالإجماع يقال بالاشتراك على معنيين
أحدهما
العزم قال الله تعالى فأجمعوا أمركم
وقال عليه الصلاة و السلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل
وثانيهما
الاتفاق يقال أجمع الرجل إذا صار ذا جمع كما
يقال ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وذا تمر فقولنا اجمعوا على كذا أي صاروا ذوي جمع عليه
وأما في اصطلاح العلماء فهو عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه و سلم على أمر من الأمور
ونعني ب الاتفاق الاشتراك إما في الاعتقاد أو القول أو
الفعل أو إذا أطبق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الإعتقاد
ونعني بأهل الحل والعقد المجتهدين في الأحكام الشرعية
وإنما قلنا على أمر من الأمور ليكون متناولا للعقليات والشرعيات واللغويات
المسألة الثانية
من الناس من زعم أن اتفاقهم على الحكم الواحد الذي
لا يكون معلوما بالضرورة محال كما أن أتفاقهم في الساعة الواحدة على المأكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة محال
وربما قال بعضهم كما أن اختلاف العلماء في الضروريات محال فكذا اتفاقهم في النظريات محال
والجواب أن الاتفاق إنما يمتنع فيما يتساوى فيه الاحتمال كالمأكول
المعين والكلمة المعينة
أما عند الرجحان وذلك عند قيام الدلالة أو الأمارة الظاهرة فذلك غير ممتنع وذلك كاتفاق الجمع العظيم على نبوة محمد صلى الله عليه و سلم
واتفاق الشافعية والحنفية مع كثرتهما على قوليهما مع أن أكثر أقوالهما صادر عن الأمارة
ومن الناس من سلم إمكان هذا الاتفاق في نفسه لكنه قال لا طريق لنا إلى العلم بحصوله لأن العلم بالأشياء إما أن يكون وجدانيا أو لا يكون
أما الوجداني فكما يجد كل واحد منا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته وألمه إلى غير ذلك ولا شك أن العلم بحصول اتفاق أمه محمد صلى الله عليه و سلم ليس من هذا الباب
وأما الذي لا يكون وجدانيا فقد اتفقوا على أن الطريق إلى معرفته إما الحس وإما الخبر وإما النظر العقلي
أما النظر العقلي فلا مجال له في أن الشخص الفلاني قال بهذا القول
أو لم يقل به
بقي أن يكون الطريق إليه إما الحس وإما الخبر لكن من المعلوم أن الإحساس بكلام الغير أو الإخبار عن كلامه لا يمكن إلا بعد معرفته
فإذن العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحد من الأمة لكن ذلك متعذر قطعا فمن الذي يعرف جميع الناس الذين هم بالشرق والغرب
وكيف الأمان من وجود إنسان في مطمورة لا خبر عندنا منه فإنا إذا أنصفنا علمنا أن الذين بالشرق لا خبر عندهم من أحد من علماء الغرب فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذاهبه
وأيضا فبتقدير العلم بكل واحد من علماء العالم لا يمكننا معرفة اتفاقهم لأنه لا يمكن ذلك إلا بالرجوع إلى كل واحد منهم وذلك لا يفيد حصول الاتفاق لاحتمال أن بعضهم أفتى بذلك على خلاف اعتقاده تقية أو خوفا
أو لأسباب أخرى مخفية عنا
وايضا فبتقدير أن نرجع إلى كل واحد منهم ونعلم أن كل واحد منهم أفتى بذلك من صميم قلبه فهو لا يفيد حصول الإجماع لاحتمال أن علماء بلدة إذا أفتوا بحكم فعند الإرتحال عن بلدهم والذهاب إلى البلدة الأخرى رجعوا عن ذلك الحكم قبل فتوى أهل البلدة الأخرى بذلك
وعلى هذا التقدير لا يحصل الاتفاق لأنا لو قدرنا أن الأمة انقسمت إلى قسمين وأحد القسمين أفتى بحكم والآخر أفتى بنقيضه ثم انقلب المثبت نافيا والنافي مثبتا لم يحصل الإجماع
وإذا كان كذلك فمع قيام هذا الاحتمال كيف يحصل اليقين بحصول الإجماع
بل ها هنا مقام اخر وهو أن أهل العلم بأسرهم
لو اجتمعوا في موضع واحد ورفعوا أصواتهم دفعة واحدة وقالوا أفتينا بهذا الحكم فهذا مع امتناع وقوعه لا يفيد العلم بالإجماع لاحتمال أن يكون بعضهم كان مخالفا فيه فخاف من مخالفة ذلك الجمع العظيم أو خاف ذلك الملك الذي أحضرهم أو أنه أظهر المخالفة لكن خفى صوته فيما بين أصواتهم
فثبت أن معرفة الإجماع ممتنعة
فإن قلت ما ذكرتموه باطل بصور
إحداها
أنا نعلم بالضرورة أن المسلمين معترفون بنبوة محمد صلى الله عليه و سلم وبوجوب الصلوات الخمس ونعلم اتفاق أصحاب الشافعي على القول ببطلان البيع الفاسد واتفاق الحنفية على القول بانعقاد وإن كانت الوجوه التي ذكرتموها بأسرها حاصلة ها هنا
وثانيها
أنا نعلم ان الغالب على أهل الروم النصرانية وعلى بلاد الفرس الإسلام وإن كنا ما لقينا كل واحد من هذه البلاد ولا كل واحد من ساكنيها
وثالثها
أن السلطان العظيم يمكنه أن يجمع الناس في موضع واحد بحيث يمكن معرفة اتفاقهم واختلافهم
قلت أما قوله نعلم بالضرورة اتفاق المسلمين على نبوة محمد صلى الله عليه و سلم
قلت إن كنت تعني بالمسلمين المعترفين بنبوة محمد صلى الله عليه و سلم فقولك نعلم اتفاق المسلمين على نبوة محمد صلى الله عليه و سلم يجرى مجرى أن يقال نعلم اتفاق القائلين بنبوة محمد صلى الله عليه و سلم على نبوة محمد صلى الله عليه و سلم
وإن كنت تعني به شيئا اخر غير نبوة محمد صلى الله عليه و سلم فلا نسلم أنا نقطع أن القائل بذلك قائل بنبوة محمد صلى الله عليه و سلم
ولا نسلم أيضا أنا نقطع بأن كل من قال نبوة محمد صلى الله عليه و سلم قال بوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وإن كنا نعترف بحصول الظن
والذي يدل عليه أن الانسان قبل الإحاطة بالمقالات الغربية والمذاهب النادرة يعتقد اعتقادا جازما أن كل المسلمين يعترفون أن ما بين الدفتين كلام الله عز و جل ثم إذا فتش عن المقالات الغربية وجد في ذلك اختلافا شديدا نحو ما يروى عن ابن مسعود أنه أنكر كون الفاتحة والمعوذتين والمعوذتين من القرآن
ويروى عن الميمونية قوم من الخوارج أنهم أنكروا كون سورة يوسف من القرآن
ويروى عن كثير من قدماء الروافض أن هذا القرآن الذي عندنا ليس هو ذلك الذي أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم بل غير وبدل ونقص عنه وزيد فيه وإذا كان كذلك علمنا
أنا وإن اعتقدنا في الشيء أنه مجمع عليه اعتقادا قويا لكن ذلك الاعتقاد لا يبلغ حد العلم ولا يرتفع عن درجة الظن
قوله نعلم استيلاء بعض المذاهب على بعض البلاد
قلنا علمنا ذلك بخبر التواتر وفرق بين معرفة حال الأكثر وبين معرفة حال الكل لأن من دخل بلدا ورأى شعائر الإسلام في جميع المحلات والسكك ظاهرة علم بالضرورة أن الغالب على أهل تلك المدينة الاسلام
فأما أن يعلم قطعا أنه ليس في البلدة أحد إلا مسلم ظاهرا وباطنا فذلك مما لا سبيل إليه ألبتة والعلم بامتناعه ضروري
قوله السلطان العظيم يمكنه جمع علماء العالم في موضع واحد
قلنا هذا السلطان المستولي على جميع معمورة العالم مما لم يوجد إلى الآن
وبتقدير وجودة فكيف يمكن القطع بأنه لم ينفلت منه أحد في أقصى الشرق الغرب او اقصى فإن ذلك الملك ليس بعلام الغيوب
وبتقدير أن لا ينفلت منه أحد فكيف يمكن القطع بأن الكل أفتوا بذلك الحكم طائعين راغبين غير مكرهين ولا مجبرين والإنصاف انه لا طريق لنا الى معرفة حصول الإجماع الا
في زمان الصحابة حيث كان المؤمنين قليلين يمكن معرفتهم بأسرهم على التفضيل
المسألة الثالثة
إجماع أمه محمد صلى الله عليه و سلم حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج
لنا وجوه
الأول
قول تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية جمع الله تعالى بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور كما لا يجوز أن يقال إن زنيت وشربت الماء عاقبتك
فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظورة
ومتابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قول أو فتوى
غير قولهم وفتواهم وإذا كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة ضرورة أنه لا خروج من القسمين
فإن قيل لا نسلم أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظورة على الاطلاق ولم لا يجوز أن يكون كونها محظورة مشروطا بمشاقة الرسول صلى الله عليه و سلم ولا تكون محظورة بدون هذا الشرط خرج على هذا قوله إن زنيت وشربت الماء عاقبتك لأن شرب الماء غير محظور لا مطلقا ولا بشرط الزنا
فإن قلت إذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما عند حصول المشاقة وجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا عند حصول المشاقة لأنه لا خروج عن القسمين لكن ذلك باطل لأن المشاقة ليست عبارة عن المعصية كيف كانت وإلا لكان كل
من عصى الرسول صلى الله عليه و سلم مشاقا له بل هي عبارة عن الكفر به وتكذيبه
وإذا كان كذلك لزم وجوب العمل بالإجماع عند تكذيب الرسول عليه الصلاة و السلام وذلك باطل لأن العلم بصحة الإجماع متوقف على العلم بالنبوة فايجاب العمل به حال عدم العلم بالنبوة يكون تكليفا بالجمع بين الضدين وهو محال
قلت لا نسلم أنه إذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما عند المشاقة كان اتباع سبيل المؤمنين واجبا عند المشاقة لأن بين القسمين ثالثا وهو عدم الاتباع أصلا
سلمنا أنه يلزم وجوب اتباع سبيل المؤمنين عند المشاقة لكن لا نسلم أنه ممتنع
قوله المشاقة لا تحصل إلا عند الكفر به وإيجاب العمل بالإجماع عند حصول الكفر محال
قلنا لا نسلم أن المشاقة لا تحصل إلا مع الكفر
بيانه أن المشاقة مشتقة من كون أحد الشخصين في شق وكون الآخر في الشق الآخر وذلك يكفي فيه أصل المخالفة سواء بلغ حد الكفر أو لم يبلغه سلمنا أن المشاقة لا تحصل إلا عند الكفر فلم قلت إن حصول الكفر ينافي تمكن العمل بالاجماع
بيانه أن الكفر بالرسول صلى الله عليه و سلم كما يكون بالجهل بكونه صادقا فقد يكون أيضا بأمور أخر كشد الزنار ولبس الغيار وإلقاء المصحف في القاذورات والاستخفاف بالنبي صلى الله عليه و سلم مع الاعتراف بكونه نبيا وإنكار نبوته باللسان مع العلم بكونه نبيا وشيء من هذه الأنواع من الكفر لا ينافي العلم بوجوب الإجماع
سلمنا هذه المنافاة فلم قلت إنها مانعة من التكليف بيانه أن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن فيكون أبو لهب مكلفا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن وذلك متعذر
وهذ التوجيه ظاهر أيضا في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وإن أؤلئك الذي أخبر الله عنهم بهذا الخبر كانوا مكلفين بالإيمان فكانوا مكلفين بتصديق هذه الآية وباقي التقرير ظاهر
سلمنا أن هذه الآية تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المؤمنين لا بشرط مشاقة الرسول لكن بشرط تبين الهدى أولا بهذا الشرط
الأول مسلم والثاني ممنوع
بيانه أنه تعالى ذكر مشاقة الرسول صلى الله عليه و سلم وشرط فيها تبين الهدى ثم عطف عليها اتباع غير سبيل المؤمنين فوجب أن يكون تبين الهدى شرطا في التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين لأن ما كان شرطا في المعطوف عليه يجب أن يكون شرطا في المعطوف واللام في الهدى للاستغراق فيلزم أن لا يحصل التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين إلا عند تبين جميع أنواع الهدى ومن جملة أنواع الهدى ذلك الدليل الذي لأجله ذهب أهل الإجماع إلى ذكر الحكم
وعلى هذا التقدير لا يبقى للتمسك بالإجماع فائدة
وأيضا فالإنسان إذا قال لغيره إذا تبين لك صدق فلان فاتبعه فهم منه تبين صدق قوله بشيء غير قوله فكذا
ها هنا يجب أن يكون تبين صحة إجماعهم بشيء وراء إجماعهم وإذا كنا لا نتمسك بالإجماع إلا بعد دليل منفصل على صحة ما أجمعوا عليه لم يبق للتمسك بالإجماع أثر وفائدة
سلمنا انها تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المؤمنين ولكن عن متابعة كل ما كان غير سبيل المؤمنين أو عن متابعة بعض ما كان كذلك
الأول ممنوع وبتقدير التسليم فالاستدلال ساقط أما المنع فلأن لفظ الغير ولفظ السبيل كل واحد منهما لفظ منفرد فلا يفيد العموم
وأما أن بتقدير التسليم فالاستدلال ساقط لأنه يصير معنى الآية أن كل من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما كان سبيل المؤمنين يستحق
العقاب وهذا لا يقتضي أن يكون المتبع لبعض ما غاير سبيل المؤمنين مستحقا للعقاب
والثاني مسلم ونقول بموجبه فإن عندنا يحرم بعض ما غاير بعض سبيل المؤمنين أو بعض ما غاير كل سبيل المؤمنين أو كل ما غاير بعض سبيل المؤمنين وهو السبيل الذي صاروا به مؤمنين والذي يغايره هو الكفر بالله تعالى وتكذيب الرسول صلى الله عليه و سلم وهذا التأويل متعين لوجهين
أحدهما أنا إذا قلنا لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من متابعة غير سبيل الصالحين فيما به صاروا غير صالحين ولا يفهم منه المنع من متابعة سبيل غير الصالحين في كل شيء حتى في الأكل والشرب
وثانيهما أن الآية نزلت في رجل ارتد وذلك يدل على أن الغرض منها المنع من الكفر
سلمنا حظر اتباع غير سبيلهم مطلقا لكن لفظ السبيل حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي وهو غير مراد ها هنا بالاتفاق فصار الظاهر متروكا فلا بد من صرفه إلى المجاز وليس البعض أولى من البعض فتبقى الآية مجملة
وأيضا فإنه لا يمكن جعله مجازا عن اتفاق الأمة على الحكم لأنه لا مناسبة ألبتة بين الطريق المسلوك وبين اتفاق أمة محمد صلى الله عليه و سلم على شيء من الأحكام وشرط حسن التجوز حصول المناسبة
سلمنا أنه يجوز جعله مجازا عن ذلك الاتفاق لكن يجوز أيضا جعله مجازا عن الدليل الذي لأجله اتفقوا على ذلك الحكم فإنهم إذا أجمعوا على الشيء فإما أن يكون ذلك الإجماع عن استدلال أو لا عن استدلال فإن كان عن استدلال فقد حصل لهم سبيلان الفتوى والاستدلال فلم كان حمل الآية على الفتوى أولى من حملها على
الاستدلال على الفتوى
بل هذا أولى فإن بين الدليل الذي يدل على ثبوت الحكم وبين الطريق الذي يحصل فيه المشي مشابهة فإنه كما أن الحركة البدنية في الطريق المسلوك توصل البدن إلى المطلوب فكذا الحركة الذهنية في مقدمات ذلك الدليل توصل الذهن إلى المطلوب والمشابهة إحدى جهات حسن المجاز
وإذا كان كذلك كانت الآية تقتضي إيجاب اتباعهم في سلوك الطريق الذي لأجله اتفقوا على الحكم ويرجع حاصله إلى إيجاب الاستدلال بما استدلوا به على ذلك الحكم
وحينئذ يخرج الإجماع عن كونه حجة
و أما إن كان إجماعهم لا عن استدلال والقول لا عن استدلال خطأ فيلزم إجماعهم على الخطأ وذلك يقدح في صحة الإجماع
سلمنا دلالة الآية على تحريم متابعة غير قولهم لكن لا نسلم أن كلمة من للعموم وأن لفظ المؤمنين لعموم فإنا لو حملناه على للعموم لزم تطرف التخصيص إلى الآية لعدم دخول العوام والمجانين والنساء والصبيان في الإجماع
سلمنا ذلك لكن لم قلت إنه يلزم من حظر اتباع غير سبيلهم وجوب اتباع سبيلهم
بيانه أن لفظ غير وإن كان يستعمل في الاستثناء لكنهم أجمعوا على أنه في الأصل للصفة
وإذا كان كذلك كان بين اتباع غير سبيل المؤمنين وبين اتباع سبيلهم قسم ثالث وهو ترك الاتباع
فإن قلت ترك متابعة سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين فمن ترك متابعة سبيلهم فقد اتبع غير سبيلهم
قلت لم لا يجوز أن يقال الشرط في كون الإنسان متابعا لغيره كونه آتيا بمثل فعل الغير لأجل أن ذلك الغير أتى به فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين وهو إنما تركه لأجل أن غير المؤمنين تركوه كان متبعا في ذلك سبيل غير المؤمنين
أما من تركه لأن الدليل دل عنده على وجوب ذلك الترك أو لأنه لما لم يدل شيء على متابعة المؤمنين تركه على الأصل لم يكن ها هنا متبعا لأحد فلا يدخل تحت الوعيد
سلمنا دلالة الآية على وجوب متابعة سبيل المؤمنين لكن في كل الأمور أو في بعضها
الأول ممنوع لوجوه
أحدها أن المؤمنين إذا اتفقوا على فعل شيء من المباحات فلو وجب اتباع سبيلهم في كل الأمور لزم التناقض لأنه يجب عليهم فعله من حيث إنهم فعلوه ولا يجب ذلك لحكمهم بأنه غير واجب
وثانيها أن أهل الإجماع قبل اتفاقهم على ذلك الحكم كانوا متوقفين في المسألة غير جازمين بالحكم بل كانوا جازمين بأنه يجوز البحث عنها ويجوز الحكم لكل أحد بما أدى إليه اجتهاده ثم إنهم بعد الإجماع قطعوا بذلك الحكم فلو وجب متابعتهم في كل ما يقولونه لزم اتباعهم في النقيضين وهو محال
فإن قلت الإجماع الأول على تجويز التوقف وطلب الدلالة والحكم بما أدى إليه الاجتهاد ما كان مطلقا بل كان بشرط عدم الاتفاق على حكم واحد فإذا حصل الاتفاق زال شرط الإجماع فزال بزواله
قلت المفهوم من عدم حصول الإجماع حصول الخلاف فلو
شرطنا تجويز الخلاف بعدم الإجماع لزم أن يكون تجويز وجود الشيء مشروطا بوجوده
وأيضا ف لو جاز في أحد الإجماعين أن يكون مشروطا بشرط جاز أيضا في الإجماع الثاني والثالث ويلزم منه أن لا يستقر شيء من الإجماعات
وثالثها أن اتفاق المجمعين على ما أجمعوا عليه إما أن لا يكون عن استدلال أو يكون عن استدلال
والأول باطل لأن القول بغير استدلال خطأ بالإجماع فلو اتفق أهل الإجماع عليه كانوا مجمعين على الخطأ وذلك يقدح في كون الإجماع حجة
وإذا كان الثاني فذلك الدليل إما الإجماع أو غيره
والأول باطل لأن الإجماع إما أن يكون نفس حكمهم أو نتيجة حكمهم والدليل على الحكم متقدم على الحكم
والثاني يقتضي أن يكون سبيل المؤمنين إثبات ذلك الحكم بغير الإجماع فيكون إثباته بالإجماع اتباعا لغير سبيلهم فوجب أن لا يجوز
فظهر أنا لو حملنا الآية على اقتضاء متابعة المؤمنين في كل الأمور لزم التناقض
وإذا بطل ذلك وجب حملها على اقتضاء المتابعة في بعض الأمور وحينئذ نقول بموجبه ونحمله على الإيمان بالله تعالى ورسوله
ثم الذي يؤكد هذا الاحتمال وجوه
أحدها أن القائل إذا قال اتبع سبيل الصالحين فهم منه الأمر باتباعهم فيما به صاروا صالحين فكذا ها هنا
وثانيها أنا إذا حملنا الآية على ذلك كان ذلك السبيل حاصلا في الحال ولو حملناه على إجماعهم على الحكم الشرعي
كان ذلك مما سيصير سبيلا في المستقبل لأنه لا يوجد إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة و السلام فالحمل على الأول إولى
وثالثها أن السلطان إذا قال و من يشاقق وزيري من الجند ولم يتبع سبيل فلان ويشير به إلى اقوام متظاهرين في طاعة الوزير عاقبتهم فإنه انما يعنى بالسبيل المذكور سبيلهم في طاعة الوزير دون سائر السبل
سلمنا دلالة الآية على وجوب المتابعة في كل الأمور لكنها تدل على وجوب متابعة بعض المؤمنين أو كلهم
الأول باطل لأن لفظ المؤمنين جمع فيفيد الاستغراق ولأن إجماع البعض غير معتبر بالإجماع ولأن أقوال الفرق متناقضة
والثاني مسلم ولكن كل المؤمنين هم الذين يوجدون إلى
قيام الساعة فلا يكون الموجودون في العصر كل المؤمنين فلا يكون إجماعهم إجماع كل المؤمنين
فإن قلت المؤمنون هم المصدقون وهم الموجودون وأما الذين لم يوجدوا بعد فليسوا بمؤمنين
قلت إذا وجد أهل العصر الثاني ففي العصر الثاني لا يصح القول بأن أهل العصر الأول هم كل المؤمنين فلا يكون اجماع أهل العصر الأول عند حصول أهل العصر الثاني قولا لكل المؤمنين فلا يكون إجماع أهل العصر الأول حجة على أهل العصر الثاني
سلمنا أن أهل العصر هم كل المؤمنين لكن الآية إنما نزلت في زمان الرسول صلى الله عليه و سلم فتكون الآية مختصة بمؤمني ذلك الوقت وهذا يقتضي أن يكون إجماعهم حجة لكن التمسك بالإجماع إنما ينفع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم فما لم يثبت أن الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الآية بقوا بأسرهم إلى ما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم
وأنه اتفقت كلمتهم على الحكم الواحد لم تدل هذه الآية على صحة ذلك الإجماع ولكن ذلك غير معلوم في شيء من الإجماعات الموجودة في المسائل بل المعلوم خلافه لأن كثيرا منهم مات زمان حياة الرسول صلى الله عليه و سلم فسقط الاستدلال بهذه الآية
سلمنا دلالاتها على وجوب متابعة مؤمني كل عصر لكن المراد متابعة كل مؤمني ذلك العصر أو بعضهم
الأول باطل وإلا لاعتبر في الإجماع قول العوام بل الأطفال والمجانين
والثاني نقول به لأن عندنا يجب في كل عصر متابعة بعض من كان فيه من المؤمنين وهو الإمام المعصوم
سلمنا أن المراد متابعة جميع مؤمني العصر لكن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب وهو أمر غائب عنا فكيف يعلم في المجمعين كونهم مصدقين بقلوبهم لاحتمال أنهم وإن كانوا
مصدقين باللسان لكنهم كفرة بالقلب وإذا جهلنا ذلك جهلنا كونهم مؤمنين وإذا كان الواجب علينا اتباع المؤمنين فمتى جهلنا كونهم مؤمنين لم يجب علينا اتباعهم
وهو أيضا لازم على المعتزلة القائلين بأن المؤمن هو المتسحق للثواب لأن ذلك غير معلوم أيضا
وأيضا فالأمة متى أجمعت لم نعلم كونهم مستحقين للثواب إلا بعد العلم بكونهم محقين في ذلك الحكم إذ لو لم نعلم ذلك لجوزنا كونهم مخطئين وأن يكون خطؤهم كثيرا يخرجهم عن استحقاق الثواب واسم الايمان
فإذن إنما نعرف كون المجمعين مؤمنين إذا عرفنا أن ذلك الحكم صواب فلو استفدنا العلم بكونه صوابا من إجماعهم لزم الدور
فإن قلت لم لا يجوز أن يكون المراد من المؤمنين المصدقين باللسان كما في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن
قلت لا شك أن إطلاق اسم المؤمنين على المصدقين باللسان دون القلب مجاز فإذا جاز لكم حمل الآية على هذا المجاز فلم لا يجوز لنا حملها على مجاز آخر وهو أن نقول المراد إيجاب متابعة السبيل الذي من شأنه أن يكون سبيلا للمؤمنين كما إذا قيل اتبع سبيل الصالحين لا يراد به وجوب اتباع سبيل من يعتقد فيه كونه صالحا بل وجوب اتباع السبيل الذي يجب أن يكون سبيلا للصالحين
سلمنا دلالة الآية على كون الإجماع حجة لكن دلالة
قطيعة أم ظنية
الأول ممنوع والثاني مسلم لكن المسألة قطعية فلا يجوز التمسك فيها بالدلائل الظنية
بيانه ما تقدم في كتاب اللغات أن التمسك بالدلائل اللفظية لا يفيد اليقين ألبتة
فإن قلت إنا نجعل هذه المسألة ظنية
قلت إن أحدا من الأمة لم يقل إن الإجماع المنعقد بصريح القول دليل ظني بل كلهم نفوا ذلك فإن منهم من نفى كونه دليلا أصلا
ومنهم من جعله دليلا قاطعا فلو أثبتناه دليلا ظنيا لكان هذا تخطئه لكل الأمة وذلك يقدح في الإجماع
والعجب من الفقهاء أنهم أثبتوا الإجماع بعمومات الآيات
والأخبار وأجمعوا على أن المنكر لما تدل عليه هذه العمومات لا يكفر ولا يفسق إذا كان ذلك الإنكار لتأويل ثم يقولون الحكم الذي دل عليه الإجماع مقطوع به ومخالفه كافر أو فاسق فكأنهم قد جعلوا الفرع أقوى من الأصل وذلك غفلة عظيمة
سلمنا دلالة هذه الآية على أن الإجماع حجة لكنها معارضة بالكتاب والسنة والمعقول
أما الكتاب فكل ما فيه منع لكل الأمة من القول الباطل والفعل الباطل كقوله عز و جل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والنهي عن الشيء لا يجوز إلا إذا كان المنهي عنه متصورا
وأما السنة فكثيرة
أحدها قصة معاذ وأنه لم يجر فيها ذكر الإجماع ولو كان ذلك مدركا شرعيا لما جاز الإخلال بذكره عند اشتداد الحاجة إليه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
وثانيها قوله عليه الصلاة و السلام لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي
وثالثها قوله عليه السلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
ورابعها قوله عليه الصلاة و السلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينترعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
وخامسها قوله عليه الصلاة و السلام تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ما ينسى
وسادسها قوله عليه الصلاة و السلام من أشراط الساعة أن يرتفع العلم ويكثر الجهل
وهذه الأحاديث بأسرها تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات
وأما المعقول فمن وجهين
الأول أن كل واحد من الأمة جاز الخطأ عليه فوجب جوازه على الكل كما أنه لو كان كل واحد من الزنج أسود كان الكل سودا
الثاني أن ذلك الإجماع إما أن يكون لدلالة أو لأمارة أو لا لدلالة
ولا لأمارة
فإن كان لدلالة فالواقعة التي أجمع عليها كل علماء العلم تكون واقعة عظيمة ومثل هذه الواقعة مما تتوفر الدواعي على نقل الدليل القاطع الذي لأجله أجمعوا فكان ينبغي اشتهار تلك الدلالة
وحينئذ لا تبقى للتمسك بالإجماع فائدة
وإن كان لأمارة فهو محال لأن الأمارات يختلف حال الناس فيها فيستحيل اتفاق الخلق على مقتضاها
ولأن في الأمة من لم يقل بكون الأمارة حجة فلا يمكن اتفاقهم لأجل الأمارة على حكم
وإن كان لا لدلالة ولا لأمارة كان ذلك خطأ فادحا في الإجماع ولو اتفقوا عليه لكانوا متفقين على الباطل وذلك قادح في الإجماع
والجواب
قوله الآية تقتضي التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين بشرط المشاقة
قلنا هذا باطل لأن المغلق على الشرط إن لم يكن عدما عند عدم الشرط فقد حصل غرضنا
وإن كان عدما عند عدم الشرط فلو كان التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطا بالمشاقة ل كان عند عدم المشاقة اتباع غير سبيل المؤمنين جائزا مطلقا وهذا باطل لأن مخالفة الإجماع إن لم تكن خطأ لكن لا شك في أنه لا يكون صوابا مطلقا فبطل ما ذكروه
قوله تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين مشروط بتبين الهدى قلنا لا نسلم لأن تبين الهدى شرط في الوعيد عند المشاقة لا عند اتباع غير سبيل المؤمنين ولا نسلم أنه يلزم من العطف اشتراك
إحدى الجملتين بما كانت الجملة الأخرى مشروطه به
سلمنا أن العطف يقتضي الاشتراك في الاشتراط لكن الهدى الذي نتبينه شرطا في حصول الوعيد عند مشاقة الرسول هو الدليل الدال على التوحيد والنبوة لا الدليل الدال على أحكام الفروع وإذا لم يكن تبين الدليل على مسائل الفروع شرطا في لحوق الوعيد على مشاقة الرسول صلى الله عليه و سلم وجب أن لا يكون ذلك شرطا أيضا في لحوق الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين وإلا لم تكن الجملة الثانية مشروطة بالشرط المعتبر في الجملة الأولى بل بشرط لم يدل عليه الدليل أصلا
سلمنا أن مقتضى العطف ما ذكرتموه لكن معنا دليل يمنع منه من وجهين
الأول أن هذه الآية خرجت مخرج المدح للمؤمنين وتمييزهم عن غيرهم ولو حملناه على ما ذكره السائل لبطل ذلك ألا ترى أن اليهود والنصارى إذا عرفنا أن قولا من أقاويلهم هدى فإنه
يلزمنا أن نقول بمثله مع أنه لا تبعية لهم فيه
الثاني أن اتباع المؤمنين هو الرجوع إلى قولهم لأجل أنهم كانوا ه لا لأنه صح ذلك بالدليل ألا ترى أنا لا نكون متبعين لليهود والنصارى في قولنا بإثبات الصانع ونبوة موسى وعيسى عليهما السلام وإن شاركناهم في ذلك الاعتقاد لأجل أنا لم نذهب إلى ذلك لأجل قولهم
قوله لفظ الغير والسبيل ليس للجمع فلا يقتضي تحريم كل ما كان غيرا لكل ما كان سبيلا للمؤمنين
قلنا العموم حاصل من حيث اللفظ ومن حيث الإيماء
أما اللفظ فلوجهين
الأؤل أن القائل إذا قال من دخل غير داري ضربته فهم منه العموم بدليل صحة الاستثناء لكل واحد من الدور المغايرة لداره
الثاني أنا لو حملنا الآية على سبيل واحد مع أنه غير مذكور صارت الآية مجملة ولو حملناها على العموم لم يلزم ذلك وحمل كلام الله عز و جل على ما هو أكثر فائدة أولى لا سيما إذا كانت هذه اللفظة إنما تستعمل في العرف لإفادة العموم
أما الإيماء فلما سيأتي في باب القياس إن شاء الله عز و جل أن ترتيب الحكم على الإسم مشعر بكون المسمى علة لذلك الحكم فكانت عله التهديد كونه اتباعا لغير سبيل المؤمنين فيلزم عموم الحكم لعموم هذا المقتضي
قوله إذا حملناه على الكل سقط الاستدلال
قلنا ذلك إنما يلزم لو حملناه على الكل من حيث هو كل أما لو حملناه على كل واحد لم يلزم ذلك ولا شك أنه هو المتبادر إلى الفهم لأن من قال من دخل غير دارى فله كذا لا يفهم منه أنه أراد به من دخل جميع الدور المغايره لداره
قوله المراد منه المنع من متابعة غير سبيل المؤمنين فيما به صاروا غير مؤمنين وهو الكفر
قلنا لا نسلم بل الأصل اجراء الكلام على عمومه وايضا فلأنة لا معنى لمشاقة الرسول الا اتباع سبيل المؤمنين فيما به صاروا غير مؤمنين فلو حملنا قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين على ذلك لزم التكرار
قوله نزلت في رجل ارتد
قلنا تقدم بيان أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
قوله السبيل هو الطريق الذي يحصل المشي فيه
قلنا لا نسلم لقوله تعالى قل هذه سبيلي وقوله أدع إلى سبيل ربك
سلمناه لكنا نعلم بالضرورة أن ذلك غير مراد ها هنا ولا نزاع في أن أهل اللغة يطلقون لفظ السبيل على ما يختاره
الإنسان لنفسه في القول والعمل
وإذا كان ذلك مجازا ظاهرا وجب حمل اللفظ عليه لأن الأصل عدم المجاز الآخر
وحينئذ يحمل اللفظ على هذا المعنى إلى أن يذكر الخصم دليلا معارضا
وبه نجيب عن قولهم لا مناسبة بين الأتفاق على الحكم وبين الطريق الذي يحصل المشي فيه
قوله لم لا يجوز أن يكون المراد وجوب متابعتهم في الاستدلال بالدليل الذي لأجله أثبتوا ذلك الحكم
قلنا هب أن الأمر كذلك ولكن لما أمر الله تعالى باتباع سبيلهم في الاستدلال بدليلهم ثبت أن كل ما اتفقوا عليه صواب وأيضا فمن أثبت الحكم لدليل لم يكن متبعا لغيره
قوله لم قلت إن لفظة من والمؤمنين للعموم
قلنا لما تقدم في باب العموم
قوله لم قلت إنه يلزم من حظر اتباع غير سبيلهم وجوب اتباع سبيلهم
قلت لأنه يفهم في العرف من قول القائل لا تتبع غير سبيل الصالحين الأمر بمتابعة سبيل الصالحين حتى لو قال لا تتبع غير سبيل الصالحين ولا تتبع سبيلهم أيضا لكان ذلك ركيكا بلى لو قال لا تتبع سبيل غير الصالحين فإنه لا يفهم منه الأمر بمتابعة سبيلهم ولذلك لا يستقبح أن يقال لا تتبع سبيل غير الصالحين ولا سبيلهم
وبالجملة فالفرق معلوم بالضرورة في العرف بين قولنا لا تتبع غير سبيل الصالحين وبين قولنا لا تتبع سبيل غير الصالحين
قوله يجب اتباع سبيل المؤمنين في كل الأمور أو في بعضها
قلنا بل في كلها ولذلك يصح الاستثناء لأنه لما ثبت النهي
عن متابعة كل ما هو غير سبيل المؤمنين وثبت أنه لا واسطة بينها وبين اتباع سبيل المؤمنين لزم أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا في كل شيء
قوله يلزم وجوب اتباعهم في فعل المباحات
قلنا هب أن هذه الصورة مخصوصة للضرورة التي ذكرتموها فتبقى حجة فيما عداها
قوله الناس قبل حصول الإجماع كانوا مجمعين على التوقف في الحكم وطلب الدليل
قلنا الإجماع على ذلك مشروط بأن لا يحصل الاتفاق
قوله عدم الإجماع هو الاختلاف فيلزم أن يكون جواز الاختلاف مشروطا بوقوع الاختلاف
قلنا هب أنه كذلك فأي محال يلزم منه
قوله لو جاز أن يكون هذا الاجماع مشروطا لجاز مثله في سائر الإجماعات
قلنا ذلك جائز و لكن أهل الإجماع حذفوا هذا الشرط عند حصول الاتفاق على الحكم ولم يحذفوه عند الاتفاق على جواز الاختلاف
قوله أهل الإجماع أثبتوا ذلك الحكم بغير الإجماع وإثباته بالإجماع مغاير لسبيل المؤمنين
قلنا لما أثبتوا الحكم بدليل سوى الإجماع فقد فعلوا أمرين أحدهما
أنهم أثبتوا ذلك الحكم بدليل
والآخر أنهم تسمكوا بغير الاجماع والآية لما دلت على وجوب متابعتهم في كل الأمور كانت متناولة للصورتين إلا أنه ترك العمل بمقتضى الآية في إحدى الصورتين لانعقاد الإجماع على أنه لا يجب علينا الاستدلال بما استدل به أهل الإجماع فبقى العمل بها في الباقي
قوله إذا قال اتبع سبيل الصالحين فهم منه إيجاب اتباع سبيلهم فيما به صاروا صالحين
قلنا لا نسلم لأن سبيل الصالح شيء مضاف إلى الصالح
والمضاف إلى الشيء خارج عنه والصلاح جزء من ماهية الصالح وداخل فيها والخارج عن الشيء لا يكون نفس الداخل فيه
سلمنا لكن المتابعة في الصلاح ممكنة أما في الإيمان فلا لأنه لا يحصل بالتقليد وقد بينا أن الاتباع هو الاتيان بمثل فعل الغير لأجل أن ذلك الغير فعله
قوله إذا حملناه على الإيمان كان ذلك السبيل حاصلا في الحال ولو حملناه على الإجماع لم يكن حاصلا في الحال
قلنا لما دللنا على أنه لا يجوز حمله على الإيمان وجب حمله على ذلك
غايته أنه يفضي إلى المجاز لكنه مجاز سائغ لأن تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه مشهور
قوله السلطان إذا قال ومن يشاقق وزيري ويتبع غير سبيل فلان ويعني به المطيعين لذلك الوزير فهم منه أنه أراد بذلك سبيلهم في طاعته
قلنا لا نسلم فإن اللفظ يقتضي العموم وما ذكرتموه
قرينة عرفية تقتضي الخصوص والدلالة اللفظية راجحة على القرينة العرفية
قوله المراد إيجاب اتباع كل المؤمنين أو بعضهم
قلنا الكل
قوله كل المؤمنين هم الذين يوجدون إلى قيام الساعة
قلنا هذا مدفوع لوجهين
الأول أن جميع المؤمنين هم الذين دخلوا في الوجود لأن المؤمن هو المتصف بالإيمان والمتصف بالإيمان يجب أن يكون موجودا وما سيوجد في المستقبل ولم يوجد في الحال فهو غير موجود
قوله الموجودون في العصر الأول لا يصدق عليهم في العصر الثاني أنهم كل المؤمنين
قلنا لكن لما صدق عليهم في العصر الأول أنهم كل المؤمنين وهم في العصر الأول اتفقوا على أنه لا يجوز لأحد من سائر الأعصار مخالفتهم وجب أن يكون ذلك الحكم
منهم صدقا في العصر الأول فإذا ثبت في العصر الأول أن ذلك الحكم حق في كل الأعصار ثبت ذلك في كل الأعصار إذ لو لم يكن حقا في العصر الثاني لما صدق في العصر الأول أنه حق في كل الأعصار مع أنا فرضنا أن ذلك حق
الثاني أن الله عز و جل علق العقاب على مخالفة كل المؤمنين زجرا عن مخالفتهم وترغيبا في الأخذ بقولهم فلا يجوز أن يكون المراد جميع المؤمنين إلى قيام الساعة لأنه لا فائدة في التمسك بقولهم بعد قيام الساعة
قوله إذا كان المراد من المؤمنين الموجودين في ذلك العصر كانت الآية دالة على أن إجماع الموجودين في وقت نزول الآية حجة
قلنا لا يجوز أن يكون مراد الله تعالى إيجاب اتباع مؤمني ذلك العصر لأن قول المؤمنين حال حياة الرسول صلى الله
عليه وسلم إن كان مطابقا لقوله كانت الحجة في قوله لا في قولهم فيصير قولهم لغوا ولما بطل ذلك ثبت أن المراد إيجاب العمل بقول المؤمنين في أي عصر كان
قوله المراد كل مؤمني العصر أو بعضهم
قلنا ظاهره الكل إلا ما أخرجه الدليل المنفصل وهم العوام والأطفال والمجانين فبقى غيرهم وهم جمهور العلماء داخلا تحت الآية
قوله نحمله على الإمام المعصوم
قلنا هذا باطل لأن الوعيد على مخالفة المؤمنين فحمله على الواحد ترك للظاهر
قوله المراد بالمؤمن المصدق في الباطن وهو غير معلوم الوجود
قلنا المؤمن في اللغة هو المصدق باللسان فوجب حمله عليه إلى قيام المعارض
والذي يدل عليه أنه تعالى لما أوجب علينا اتباع سبيلهم فلا بد وأن نكون متمكنين من معرفتهم والاطلاع على الأحوال الباطنة ممتنع فوجب حمله على التصديق باللسان
قوله لم لا يجوز أن يكون المراد إيجاب اتباع السبيل الذي من شأنه أن يكون سبيلا للمؤمنين
قلنا هذا عدول عن الظاهر من غير ضرورة
قوله هذه الدلالة ظنية فلا يجوز إثبات الحكم القطعي بها
قلنا عندنا أن هذه المسألة ظنية ولا نسلم انعقاد الإجماع عن أنها ليست ظنية
قوله أعطيتم الفرع من القوة ما ليس للأصل
قلنا نحن لا نقول بتكفير مخالف الإجماع ولا بتفسيقه ولا نقطع أيضا به وكيف وهو عندنا ظني
قوله هذه الدلالة معارضة بالآيات الدالة على النهي