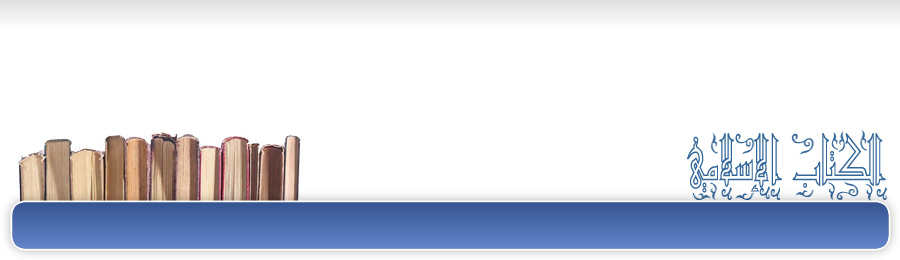كتاب : المحصول في علم الأصول
المؤلف : محمد بن عمر بن الحسين الرازي
المحصول في علم أصول الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين
الكلام في المقدمات وفيه فصول
الفصل الأول
في تفسير أصول الفقهالمركب لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداته لا من كل وجه بل من الوجه الذي لأجله يصح أن يقع التركيب فيه
فيجب علينا تعريف الأصل والفقه ثم تعريف أصول الفقه
أما الأصل فهو المحتاج إليه
وأما الفقه فهو في أصل اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه
وفي اصطلاح العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية والمستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة
فإن قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما
قلت المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه فالحكم معلوم قطعا والظن واقع في طريقه
وقولنا العلم بالأحكام احتراز عن العلم بالذوات والصفات الحقيقية
وقولنا الشرعية احتراز عن العلم بالأحكام العقلية كالتماثل والاختلاف والعلم بقبح الظلم وحسن الصدق عند من يقول بكونهما عقليين
وقولنا العملية احتراز عن العلم بكون الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة فان كل ذلك أحكام شرعية مع أن العلم بها ليس من الفقه لأن العلم بها ليس علما بكيفية عمل
وقولنا المستدل على أعيانها احتراز عما للمقلد من العلوم الكثيرة المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية لأنه إذا علم أن المفتي أفتى بهذا الحكم وعلم أن ما أفتى به المفتي هو حكم الله تعالى في حقه فهذان العلمان يستلزمان العلم بأن حكم الله تعالى في حقه ذلك مع أن تلك العلوم لا تسمى فقها لما لم يكن مستدلا على أعيانها
وقولنا بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة احتراز عن العلم بوجوب الصلاة والصوم فان ذلك لا يسمى فقها لأن العلم الضروري حاصل بكونهما من دين محمد صلى الله عليه و سلم
وأما أصول الفقه فاعلم أن إضافة اسم المعنى
تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه في المعنى الذي عينت له لفظة المضاف يقال هذا مكتوب زيد والمفهوم ما ذكرناه
وعند هذا نقول
أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها
فقولنا مجموع احتراز عن الباب الواحد من أصول الفقه فإنه وان كان من أصول الفقه لكنه ليس أصول الفقه لأن بعض الشيء لا يكون نفس ذلك الشيء
وقولنا طرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات
وقولنا على طريق الإجمال أردنا به بيان كون تلك الأدلة أدلة ألا ترى أنا إنما نتكلم في أصول الفقه في بيان أن الإجماع دليل
فأما أنه وجد الإجماع في هذه المسألة فذلك لا يذكر في أصول الفقه
وقولنا وكيفية الاستدلال بها أردنا به الشرائط التي معها يصح الاستدلال بتلك الطرق
وقولنا وكيفية حال المستدل بها أردنا به أن الطالب لحكم الله تعالى إن كان عاميا وجب أن يستفتي وان كان عالما وجب أن يجتهد فلا جرم وجب في أصول الفقه أن يبحث عن حال الفتوى والاجتهاد وأن كل مجتهد هل هو مصيب أم لا
الفصل الثاني
فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدماتلما كان أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مفضيا إما إلى العلم بالمدلول أو إلى الظن به والمدلول هنا هو الحكم الشرعي وجب علينا تعريف مفهومات هذه الألفاظ أعني العلم والظن والنظر والحكم الشرعي
ثم ما كان منها بين الثبوت كان غنيا عن البرهان وما لم يكن كذلك وجب أن يحال بيانه على العلم الكلي الناظر في الوجود ولواحقه لأن مبادئ العلوم الجزئية لو برهن عليها فيها لزم الدور
وهو محال
الفصل الثالث
في تحديد العلم والظنهذا المقصود إنما يتحقق ببحثين
الأول أن حكم الذهن بأمر على أمر إما أن يكون جازما أو لا يكون فإن كان جازما فإما أن يكون مطابقا للمحكوم عليه أو لا يكون فإن كان مطابقا فإما أن يكون لموجب أو لا يكون
فإن كان لموجب فالموجب إما أن يكون حسيا أو عقليا أو مركبا منهما
فإن كان حسيا فهو العلم الحاصل من الحواس الخمسة ويقرب منه العلم بالأمور الوجدانية كاللذة والألم
وإن كان عقليا فأما أن يكون الموجب مجرد تصور طرفي القضية أو لا بد من شيء آخر من القضايا فالأول هو البديهيات والثاني النظريات
وأما إن كان الموجب مركبا من الحس والعقل فإما أن يكون من السمع والعقل وهو المتواترات
أو من سائر الحواس والعقل وهو التجريبيات والحدسيات
وأما الذي لا يكون لموجب فهو اعتقاد المقلد
وأما الجازم غير المطابق فهو الجهل
وأما الذي لا يكون جازما فالتردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو الشك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم
الثاني أنه ليس يجب أن يكون كل تصور مكتسبا وإلا لزم الدور أو التسلسل إما في موضوعات متناهية أو غير
متناهية وهو يمنع حصول التصور أصلا بل لا بد من تصور غير مكتسب
وأحق الأمور بذلك ما يجده العاقل من نفسه ويدرك التفرقة بينه وبين غيره بالضرورة
ومنها القسم المسمى بالعلم لأن كل أحد يدرك بالضرورة ألمه ولذته ويدرك بالضرورة كونه عالما بهذه الأمور
ولولا أن العلم بحقيقة العلم ضروري وإلا لامتنع أن يكون علمه بكونه عالما بهذه الأمور ضروريا لما أن التصديق موقوف على التصور
وكذا القول في الظن
ثم العبارة المحررة أن الظن تغليب لأحد مجوزين ظاهري التجويز
وها هنا دقيقة وهي أن التغليب إما أن يكون في المعتقد أو في الاعتقاد
أما الذي يكون في المعتقد فهو أن يكون الشيء ممكن الوجود والعدم إلا أن أحد الطرفين به أولى كالغيم الرطب فإن نزول المطر منه وعدم نزوله ممكنان لكن النزول أولى
وأما الذي يكون في الاعتقاد فهو أن يحصل اعتقاد الوقوع واعتقاد اللا وقوع كل واحد مع تجويز النقيض لكن اعتقاد الوقوع يكون أظهر عنده من اعتقاد اللاوقوع
فظهر أن اعتقاد رجحان الوقوع مغاير لرجحان اعتقاد اللاوقوع
فهذا الثاني هو الظن فان كان مطابقا للمظنون كان ظنا صادقا وإلا كان ظنا كاذبا
وأما الأول وهو اعتقاد رجحان الوقوع فإن كان مطابقا للمعتقد كان علما أو تقليدا على التفصيل المتقدم وإلا كان جهلا والله أعلم
الفصل الرابع
في النظر والدليل والأمارةأما النظر فهو ترتيب تصديقات في الذهن ليتوصل بها إلى تصديقات أخر
والمراد من التصديق اسناد الذهن أمرا إلى أمر بالنفي أو بالاثبات اسنادا جازما أو ظاهرا
ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل إن كانت مطابقة لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح وإلا فهو النظر الفاسد
ثم تلك التصديقات المطابقة إما أن تكون بأسرها علوما فيكون اللازم عنها أيضا علما وإما أن تكون بأسرها ظنونا فيكون اللازم عنها أيضا ظنا
وإما أن يكون بعضها ظنونا وبعضها علوما فيكون اللازم عنها أيضا ظنا لأن حصول النتيجة موقوف على حصول جميع المقدمات فإذا كان بعضها ظنا كانت النتيجة موقوفة على الظن والموقوف على الظن ظن فالنتيجة ظنية لا محالة
وأما الدليل فهو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم
وأما الأمارة فهي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن
الفصل الخامس
في الحكم الشرعيقال أصحابنا إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير
أما الإقتضاء فإنه يتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم
إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيتناول الواجب والمحظور والمندوب والمكروه
وأما التخيير فهو الإباحة
فإن قيل هذا التعريف فاسد من أربعة أوجه
أحدهما أن حكم الله تعالى على هذا التقدير خطابه وخطاب الله تعالى كلامه وكلامه عندكم قديم فيلزم أن يكون حكم الله تعالى بالحل والحرمة قديما
وهذا باطل من ثلاثة أوجه
الأول أن حل الوطء في المنكوحة وحرمته في الأجنبية صفة فعل العبد ولهذا يقال هذا الوطء حلال أو حرام وفعل العبد محدث وصفة المحدث لا تكون قديمة
الثاني انه يقال هذه المرأة حلت لزيد بعدما لم تكن كذلك وهذا مشعر بحدوث هذه الأحكام
الثالث أنا نقول المقتضى لحل الوطء هو النكاح أو ملك
اليمين وما كان معللا بأمر حادث يستحيل أن يكون قديما فثبت أن الحكم يمتنع أن يكون قديما والخطاب قديم فالحكم لا يكون عين الخطاب
وثانيهما أن بعض الأحكام خارج عن هذا الحد وهو كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا
وثالثهما أن الحكم الشرعي قد يوجد في غير المكلف وذلك كجعل إتلاف الصبي سببا لوجوب الضمان وجعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة
ورابعها أنك أدخلت كلمة أو في الحد وهو غير جائز لأنها للترديد والحد للإيضاح وبينهما مباينة
والجواب قوله الحل والحرمة من صفات الأفعال
قلنا لا نسلم فإن عندنا لا معنى لكون الفعل حلالا إلا مجرد كونه مقولا فيه رفعت الحرج عن فاعله ولا معنى لكونه حراما إلا كونه مقولا فيه لو فعلته لعاقبتك فحكم الله تعالى هو قوله والفعل متعلق القول وليس لمتعلق القول من القول صفة وإلا لحصل للمعدوم صفة ثبوتية بكونه مذكورا ومخبرا عنه ومسمى بالاسم المخصوص
قوله إنا نقول هذه المرأة حلت لزيد بعدما لم تكن كذلك
قلنا حكم الله تعالى هو قوله في الأزل أذنت للرجل الفلاني حين وجوده في كذا فحكمه قديم ومتعلق حكمه محدث
قوله الحكم يعلل بالأسباب
قلنا المراد من السبب عندنا المعرف لا الموجب
قوله هذا التحديد يخرج عنه كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا
قلنا المراد من كون الدلوك سببا أنا متى شاهدنا الدلوك علمنا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة فلا معنى لهذه السببية إلا الإيجاب
وإذا قلنا هذا العقد صحيح لم نعن به إلا أن الشرع إذن له في الانتفاع به ولا معنى لذلك إلا الإباحة
قوله هذا التحديد يخرج عنه إتلاف الصبي ودلوك الشمس قلنا معنى قولنا إتلاف الصبي سبب لوجوب الضمان أن الولي مكلف بإخراج الضمان من ماله والرجل مكلف ب أداء الصلاة
عند الدلوك
قوله كلمة أو للترديد
قلنا مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه كان حكما وإلا فلا
الفصل السادس
في تقسيم الأحكام الشرعيةالتقسيم الأول
وهو من وجوه
خطاب الله تعالى إذا تعلق بشيء فإما أن يكون طلبا جازما أو لا يكون كذلك
فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإيجاب أو طلب الترك وهو التحريم
وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية وهو الإباحة وإما أن يترجح جانب الوجود وهو الندب أو جانب العدم وهو الكراهة فأقسام الأحكام الشرعية هي هذه الخمسة
وقد ظهر بهذا التقسيم ماهية كل واحد منها فلنذكر الآن حدودها وأقسامها
أما الواجب فالذي اختاره القاضي أبو بكر أنه ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه
وقولنا يذم تاركه خير من قولنا يعاقب تاركه لأن الله تعالى قد يعفو عن العقاب ولا يقدح ذلك في وجوب الفعل ومن قولنا يتوعد بالعقاب على تركه لأن الخلف في خبر الله تعالى محال فكان ينبغي أن لا يوجد العفو ومن قولنا ما يخاف العقاب على تركه لأن الذي يشك في وجوبه وحرمته قد يخاف من العقاب على تركه مع أنه غير واجب وقولنا شرعا إشارة إلى ما نذهب إليه من أن هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشرع
وقولنا على بعض الوجوه ذكرناه ليدخل في الحد الواجب المخير لأنه يلام على تركه إذا تركه وترك معه بدله
أيضا والواجب الموسع لأنه يلام على تركه إذا تركه في كل الوقت والواجب على الكفاية لأنه يلام على تركه إذا تركه الكل
فإن قيل هذا الحد يدخل فيه السنة فإن الفقهاء قالوا لو أن أهل محلة اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإصرار فإنهم يحاربون بالسلاح
قلت سيأتي جوابه إن شاء الله
وأما الاسم فاعلم أنه لا فرق عندنا بين الواجب والفرض والحنفية خصصوا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع
والواجب بما عرف وجوبه بدليل مظنون
قال أبو زيد رحمه الله الفرض عبارة عن التقدير
قال الله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم
وأما الوجوب فهو عبارة عن السقوط قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت إذا ثبت هذا فنحن خصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع لأنه هو الذي يعلم من حاله أن الله تعالى قدره علينا
وهذا الفرق ضعيف لأن الفرض هو المقدر لا انه الذي ثبت كونه مقدرا علما أو ظنا كما أن الواجب هو الساقط لا انه الذي ثبت كونه ساقطا علما أو ظنا وإذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محضا
و أما المحظور فهو الذي يذم فاعله شرعا
وأسماؤه كثيرة
أحدها أنه معصية واطلاق ذلك في العرف يفيد أنه فعل ما نهى الله تعالى عنه
وقالت المعتزلة إنه الفعل الذي كرهه الله تعالى والكلام فيه مبني على مسألة خلق الأعمال وارادة الكائنات
وثانيهما أنه محرم وهو قريب من المحظور
وثالثهما أنه ذنب وهو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة والمؤاخذة ولذلك لا توصف أفعال البهائم والأطفال بذلك وربما يوصف فعل المراهق به لما يلحقه من التأديب على فعله
ورابعها أنه مزجور عنه ومتوعد عليه ويفيد في العرف أن الله تعالى هو المتوعد عليه والزاجر عنه
وخامسها أنه قبيح وسيأتي الكلام فيه إنشاء الله تعالى
و أما المباح فهو الذي أعلم فاعله أو دل على أنه لا ضرر في فعله وتركه ولا نفع في الآخرة
وأما الأسماء فالمباح يقال له إنه حلال طلق
وقد يوصف الفعل بأن الإقدام عليه مباح وإن كان تركه محظورا كوصفنا دم المرتد بأنه مباح ومعناه أنه لا ضرر على من أراقه وإن كان الإمام ملوما بترك إراقته
و أما المندوب فهو الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشرع ويكون تركه جائزا
وإنما ذم الفقهاء من عدل عن جميع النوافل لاستدلالهم بذلك على استهانته بالطاعة وزهده فيها فإن النفوس تستنقص من هذا دأبه وعادته
وقولنا في نظر الشرع احتراز عن الأكل قبل ورود الشرع فإن فعله خير من تركه لما فيه من اللذة لكن ذلك الرجحان لما لم يكن مستفادا من الشرع فلا جرم انه لا يسمى مندوبا
وأما الأسماء فأحدها أنها مرغب فيه لما أنه قد بعث المكلف على فعله بالثواب
وثانيها أنه مستحب ومعناه في العرف أن الله تعالى قد أحبه
وثالثها أنه نفل ومعناه أنه طاعة غير واجبة وأن للإنسان أن يفعله من غير حتم
ورابعها أنه تطوع ومعناه أن المكلف انقاد لله تعالى فيه مع أنه قربة من غير حتم
وخامسها أنه سنة ويفيد في العرف أنه طاعة غير واجبة
ولفظ السنة مختص في العرف بالمندوب بدليل أنه يقال هذا الفعل واجب أو سنة
ومنهم من قال لفظ السنة لا يختص بالمندوب بل يتناول كل ما علم وجوبه أو ندبيته بأمر النبي صلى الله عليه و سلم أو بإدامته فعله لأن السنة مأخوذة من الإدامة ولذلك يقال الختان من السنة ولا يراد به أنه غير واجب
وسادسها أنه إحسان وذلك إذا كان نفعا موصلا إلى الغير مع القصد إلى نفعه
وأما المكروه فيقال بالاشتراك على أمور ثلاثة
أحدها ما نهي عنه نهي تنزيه وهو الذي أشعر فاعله بأن تركه خير من فعله وإن لم يكن على فعله عقاب
وثانيها المحظور وكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله أكره كذا وهو يريد به التحريم
وثالثها ترك الأولى كترك صلاة الضحى ويسمى ذلك مكروها لا لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلها والله أعلم
التقسيم الثاني
الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحاوتحقيق القول فيه أن الإنسان إما أن يصدر عنه فعله وليس هو على حالة التكليف
وإما أن يصدر عنه الفعل وهو على حالة التكليف
والأول كفعل النائم والساهي والمجنون والطفل فهذه الأفعال لا يتوجه نحو فاعليها ذم ولا مدح وإن كان قد يتعلق بها وجوب ضمان وأرش في مالهم ويجب اخراجه على وليهم
والثاني ضربان لأن القادر عليه المتمكن من العلم بحاله إن كان له فعله فهو الحسن وإن لم يكن فهو القبيح
ثم قال أبو الحسين البصري رحمه الله القبيح هو
الذي ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه أن يفعله ومعنى قولنا ليس له أن يفعله معقول لا يحتاج إلى تفسير ويتبع ذلك أن يستحق الذم بفعله
ويحد أيضا بأنه الذي على صفة لها تأثير في استحقاق الذم
وأما الحسن فهو ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحالة أن يفعله
وأيضا ما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم
وأقول هذه الحدود غير وافية بالكشف عن المقصود
أما الأول فنقول ما الذي أردت بقولك ليس له أن يفعله
فإنه يقال للعاجز عن الفعل ليس له أن يفعله ويقال للقادر على الفعل إذا كان ممنوعا عنه حسا ليس له أن يفعله ويقال للقادر إذا كان شديد النفرة عن الفعل ليس له أن يفعله وقد يقال للقادر إذا زجره الشرع عن الفعل إنه ليس له أن يفعله
والتفسيران الأولان غير مرادين لا محالة والثالث غير مراد أيضا لأن الفعل قد يكون حسنا مع قيام النفرة الطبيعية عنه وبالعكس
والرابع أيضا غير مراد لأنه يصير القبيح مفسرا بالمنع الشرعي
فإن قلت المراد منه القدر المشترك بين هذه الصور الأربع من مسمى المنع
قلت لا نسلم أن هذه الصور الأربع تشترك في مفهوم واحد وذلك لأن المفهوم الأول معناه أنه لا قدرة له على الفعل
وهذا إشارة إلى العدم والمفهوم الرابع معناه أنه يعاقب عليه وهذا إشارة إلى الوجود ونحن لا نجد بينهما قدرا مشتركا
وأما قوله ويتبع ذلك أن يستحق الذم بفعله
قلنا لما فسرت القبيح بأنه الذي يستحق الذم بفعله وجب تفسير الاستحقاق والذم
فأما الاستحقاق فقد يقال الأثر يستحق المؤثر على معنى أنه يفتقر إليه لذاته ويقال المالك يستحق الانتفاع بملكه على معنى أنه يحسن منه ذلك الانتفاع
والأول ظاهر الفساد والثاني يقتضي تفسير الاستحقاق بالحسن مع أنه فسر الحسن بالاستحقاق حيث قال الحسن هو الذي لا يستحق فاعله الذم فيلزم الدور
وإن أراد بالاستحقاق معنى ثالثا فلا بد من بيانه
وأما الذم فقد قالوا إنه قول أو فعل أو ترك
قول أو ترك فعل ينبىء عن اتضاع حال الغير
فنقول إن عنيت بالإتضاع ما ينفر عنه طبع الإنسان ولا يلائمه فهذا معقول لكن يلزم عليه أن لا يتحقق الحسن والقبح في حق الله تعالى لما أن النفرة الطبيعية عليه ممتنعة
وإن عنيت به أمرا آخر فلا بد من بيانه
وأعلم أن هذه الاشكالات غير واردة على قولنا لأنا نعني بالقبيح المنهي عنه شرعا وبالحسن ما لا يكون منهيا عنه شرعا
وتندرج فيه أفعال الله تعالى وأفعال المكلفين من الواجبات والمندوبات والمباحات وأفعال الساهي والنائم والبهائم
وهو أولى من قول من قال الحسن ما كان مأذونا فيه شرعا لأنه يلزم عليه أن لا تكون أفعال الله تعالى حسنة ولو قلت الحسن هو الذي
يصح من فاعله أن يعلم أنه غير ممنوع عنه شرعا خرج عنه فعل النائم والساهي والبهيمة ويدخل فيه فعل الله تعالى لأن وجوب ذلك العلم لا ينافي صحته وبالله التوفيق
التقسيم الثالث
قالوا خطاب الله تعالى كما قد يرد بالاقتضاء أو التخييرفقد يرد أيضا بجعل الشيء سببا و شرطا و مانعا
فلله تعالى في الزاني حكمان أحدهما وجوب الحد عليه والثاني جعل الزنا سببا لوجوب الحد لأن الزنا لا يوجب الحد بعينه وبذاته بل بجعل الشارع إياه سببا
ولقائل أن يقول إن كان المراد من جعل الزنا سببا لوجوب الحد هو أنه قال متى رأيت انسانا يزني فاعلم أني أوجبت
عليه الحد فهو حق ولكن يرجع حاصله إلى كون الزنا معرفا بحصول الحكم
وإن كان المراد أن الشرع جعل الزنا مؤثرا في هذا الحكم فهذا باطل لثلاثة أوجه
الأول أن حكم الله تعالى كلامه وكلامه قديم والقديم لا يعلل بالمحدث
الثاني أن الشرع لما جعل الزنا مؤثرا في وجوب هذا الحد فبعد هذا الجعل إما أن تبقى حقيقة الزنا كما كانت قبل هذا الجعل أو لا تبقى فإن بقيت كما كانت وحقيقته قبل هذا الجعل ما كانت مؤثرة فبعد هذا الجعل وجب أن لا تصير مؤثرة
وإن لم تبق تلك الحقيقة كان هذا إعداما لتلك الحقيقة
والشيء بعد عدمه يستحيل أن يكون موجبا
الثالث الشرع إذا جعل الزنا علة فإن لم يصدر عنه عند ذلك
الجعل أمر ألبتة استحال أن يقال إنه جعله علة للحد لأن ذلك كذب والكذب على الشرع محال
وإن صدر عنه أمر فذلك الأمر إما أن يكون هو الحكم أو ما يوجب الحكم أولا الحكم ولا ما يوجبه
فإن كان الأول كان المؤثر في ذلك الحكم هوالشرع لا ذلك السبب
وإن كان الثاني كان المؤثر في ذلك الحكم وصفا حقيقيا وهذا هو قول المعتزلة في الحسن والقبح وسنبطله إن شاء الله تعالى
وإن كان الثالث فهو محال لأن الشارع لما أثر في شيء غير الحكم وغير مستلزم للحكم لم يكن لذلك الشيء تعلق بالحكم أصلا
التقسيم الرابع
الحكم قد يكون حكما بالصحة وقد يكون حكما بالبطلان والصحة قد تطلق في العبادات تارة وفي العقود أخرىأما في العبادات فالمتكلمون يريدون بصحتها كونها موافقة للشريعة سواء وجب القضاء أو لم يجب
والفقهاء يريدون بها ما أسقط القضاء فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة في عرف المتكلمين لأنها موافقة للأمر المتوجه عليه والقضاء وجب بأمر متجدد
وفاسدة عنه الفقهاء لأنها لا تسقط القضاء
وأما في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه
وأما الفاسد فهو مرادف للباطل عند أصحابنا
والحنفية جعلوه قسما متوسطا بين الصحيح والباطل وزعموا أنه الذي يكون منعقدا بأصله ولا يكون مشروعا بسبب وصفه كعقد الربا فإنه مشروع من حيث إنه بيع وممنوع من حيث إنه يشتمل على الزيادة
والكلام في هذه المسألة مذكور في الخلافيات ولو ثبت هذا القسم لم نناقشهم في تخصيص اسم الفاسد به
ويقرب من هذا الباب البحث عن قولنا في العبادات إنها مجزية أم لا
وأعلم أن الفعل إنما يوصف بكونه مجزيا إذا كان بحيث يمكن وقوعه بحيث يترتب عليه حكمه ويمكن وقوعه بحيث لا يترتب عليه حكمه كالصلاة والصوم والحج
أما الذي لا يقع إلا على وجه واحد كمعرفة الله تعالى ورد الوديعة فلا يقال فيه إنه مجزىء أو غير مجزىء
إذا عرفت هذه فنقول
معنى كون الفعل مجزيا أن الإتيان به كاف في سقوط التعبد به وإنما يكون كذلك لو أتى المكلف به مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد به
ومنهم من فسر الإجزاء ب سقوط القضاء وهو باطل لأنه لو أتى بالفعل عند اختلال بعض شرائطه ثم مات لم يكن الفعل مجزيا مع سقوط القضاء
ولأن القضاء إنما يجب بأمر متجدد على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
ولأنا نعلل وجوب القضاء بأن الفعل الأول لم يكن مجزيا فوجب قضاؤه والعلة مغايرة للمعلول
التقسيم الخامس
العبادة توصف بالقضاء والأداء والإعادةفالواجب إذا أدي في وقته سمي أداء
وإذا أدي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع سمي قضاء
وإن فعل مرة على نوع من الخلل ثم فعل ثانيا في وقته المضروب له سمي إعادة فالإعادة اسم لمثل ما فعل على ضرب من الخلل
والقضاء اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود
ثم ها هنا بحثان
الأول لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه لو لم يشتغل به لمات
فها هنا لو أخر عصى فلو أخر وعاش ثم اشتغل به قال
القاضي أبو بكر هذا قضاء لأنه تعين وقته بسبب غلبة الظن وما أوقعه فيه
وقال الغزالي رحمه الله هذا أداء لأنه لما انكشف خلاف ما ظن زال حكمه فصار كما لو علم أنه يعيش
الثاني الفعل لا يسمى قضاء إلا إذا وجد سبب وجوب الأداء مع أنه لم يوجد الأداء
ثم القضاء على قسمين
أحدهما ما وجب الأداء فتركه وأتى بمثله خارج الوقت فكان قضاء وهو كمن ترك الصلاة عمدا في وقتها ثم أداها خارج الوقت
وثانيهما ما لا يجب الأداء وهو أيضا قسمان
أحدهما أن يكون المكلف بحيث لا يصح منه الأداء
والثاني أن يصح منه ذلك
أما الذي لا يصح منه الأداء فإما أن يمتنع ذلك عقلا كالنائم والمغمى عليه فإنه يمتنع عقلا صدور فعل الصلاة منه
وإما أن يمتنع ذلك منه شرعا كالحائض فإنه لا يصح منها فعل الصوم لكن لما وجد في حقها سبب الوجوب وإن لم يوجد الوجوب سمي الإتيان بذلك الفعل خارج الوقت قضاء
وأما الذي يصح ذلك الفعل منه إن لم يجب عليه الفعل فالمقتضى لسقوط الوجوب قد يكون من جهته كالمسافر فإن السفر منه وقد أسقط وجوب الصوم
وقد يكون من الله تعالى كالمريض فإن المرض من الله وقد أسقط وجوب الصوم
ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء إنما جاء لأنه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب لا لأنه وجد وجوب الفعل كما يقوله بعض من لا يعرف من الفقهاء لأن المنع من الترك جزء ماهية
الوجوب فيستحيل تحقق الوجوب مع جواز الترك
التقسيم السادس
الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان بهإما أن يكون عزيمة أو رخصة وذلك لأن ما جاز فعله إما أن يجوز مع قيام المقتضى للمنع أو لا يكون كذلك
فالأول الرخصة والثاني العزيمة
فما أباحه الله تعالى في الأصل من الأكل والشرب لا يسمى رخصة ويسمى تناول الميتة رخصة وسقوط رمضان عن المسافر رخصة
ثم الذي يجوز فعله مع قيام المقتضى للمنع قد يكون واجبا كأكل الميتة والافطار عند خوف الهلاك من الجوع وقد لا يكون واجبا كالافطار والقصر في السفر وقول كلمة الكفر عند الإكراه
ولما تكلمنا في الحكم الشرعي وأقسامه فلنبين أنه ثابت بالعقل أو بالشرع
الفصل السابع
في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرعالحسن والقبح قد يعنى بهما كون الشيء ملائما للطبع أو منافرا وبهذا التفسير لا نزاع في كونهما عقليين
وقد يراد بهما كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح ولا نزاع أيضا في كونهما عقليين بهذا التفسير
وإنما النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلا وعقابه آجلا فعندنا أن ذلك لا يثبت إلا بالشرع
وعند المعتزلة ليس ذلك إلا لكون الفعل واقعا على وجه مخصوص لأجله يستحق فاعله الذم قالوا وذلك الوجه قد يستقل العقل بإدراكه وقد لا يستقل
أما الذي يستقل فقد يعلمه العقل ضرورة كالعلم بحسن
الصدق النافع وقبح الكذب الضار وقد يعلمه نظرا كالعلم بحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع
والذي لا يستقل العقل بمعرفته فكحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم الذي بعده فإن العقل لا طريق له إلى العلم بذلك لكن الشرع لما ورده به علمنا أنه لولا اختصاص كل واحد منهما بما لأجله حسن وقبح وإلا لامتنع ورود الشرع به
لنا أن دخول هذه القبائح في الوجود إما أن يكون على سبيل الاضطرار أو على سبيل الاتفاق وعلى التقديرين فالقول بالقبح العقلي باطل
بيان الأول أن فاعل القبيح إما أن يكون متمكنا من الترك أولا يكون فإن لم يتمكن من الترك فقد ثبت الاضطرار وإن تمكن من الترك فإما أن يتوقف رجحان الفاعلية على التاركية على مرجح أو لا يتوقف فإن توقف فذلك المرجح إما أن يكون من العبد أو من غيره أو لا منه ولا من غيره
أما القسم الأول وهو أن يكون من العبد فهو محال لأن الكلام فيه كما في الأول فيلزم التسلسل
وأما القسم الثاني وهو أن يكون من غير العبد فنقول عند حصوله ذلك المرجح إما أن يجب وقوع الأثر أو لا يجب
فإن وجب فقد ثبت الاضطرار لأن قبل وجود هذا المرجح كان الفعل ممتنع الوقوع وعند وجوده صار واجب الوقوع وليس وقوع هذا المرجح بالعبد ألبتة فلم يكن للعبد تمكن في شيء من الأحوال من الفعل والترك ولا معنى للاضطرار إلا ذلك
وإن لم يجب فعند حصول هذا المرجح لا يمتنع وجود الفعل تارة وعدمه أخرى فترجح جانب الوجود على جانب العدم أما أن يتوقف على انضمام مرجح إليه أو لا يتوقف فإن توقف لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحا تاما وكنا قد فرضناه مرجحا تاما هذا خلف
وأيضا فالكلام في هذه الضميمة كما في الأول فيلزم التسلسل وهو محال
وأما إن لم يتوقف على انضمام قيدالية فمع ذلك المرجح تارة يوجد الأثر وتارة لا يوجد ولم يكن رجحان جانب الوجود على
جانب العدم موقوفا على قصد من جهته ولا على ترجيح ألبتة وإلا لعاد إلى القسم الأول وقد أبطلناه
فحينئذ يكون دخول الفعل في الوجود اتفاقيا لا اختياريا فقد ثبت الاتفاق
وأما القسم الثالث وهو أن يكون حصول ذلك المرجح لا من العبد ولا من غيره فحينئذ يكون واقعا لا لمؤثر فيكون حصوله اتفاقيا لا اختياريا
وأما لو قلنا إن المتمكن من الفعل متمكن من الترك لكن لا يتوقف رجحان الفاعلية علي التاركية على مرجح فعلى هذا التقدير يكون رجحان الفاعلية على التاركية اتفاقيا أيضا لأن تلك القادرية لما كانت نسبتها إلى الأمرين على السوية ثم حصلت الفاعلية في أحد الوقتين دون التاركية من غير مرجح ألبتة كان رجحان الفاعلية منه على التاركية اتفاقيا
فإن قلت لم لا يجوز أن يقال القادر يرجح الفاعلية على التاركية من غير مرجح قلت هل لقولك يرجح مفهوم زائد على كونه قادرا أو ليس له مفهوم زائد عليه
فإن كان ذلك مفهوما زائدا على كونه قادرا كان ذلك قولا بأن رجحان الفاعلية على التاركية لا يمكن إلا عند انضمام قيد آخر إلى القادرية فيصير هذا هو القسم الأول الذي تكلمنا فيه
وإن لم يكن ذلك مفهوما زائدا لم يبق لقولكم القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح إلا أن صفة القادرية مستمرة في الأزمان كلها
ثم إنه يوجد الأثر في بعض تلك الأزمنة دون بعض من غير أن يكون ذلك القادر قد رجحه أو قصد ايقاعه ولا معنى للاتفاق إلا ذلك فثبت بهذا البرهان القاطع أن دخول هذه القبائح في الوجود إما أن يكون على سبيل الاضطرار أو على سبيل الاتفاق وإذا ثبت ذلك امتنع القول القبع العقلي بالإتفاق
أما على قولنا فظاهر
وأما عند الخصم فلأنه لا يجوز ورود التكليف بذلك فضلا عن أن يقال إن حسنه معلوم بضرورة العقل
فثبت بما ذكرنا أن القول ب القبح العقلي باطل
أما الخصم فقد ادعى العلم الضروري بقبح الظلم والكذب والجهل وبحسن الانصاف والصدق والعلم
ثم قالوا هذا العلم غير مستفاد من الشرع لأن البراهمة مع انكارهم الشرائع عالمون بهذه الأشياء
ثم زعموا بعد ذلك أن المقتضي لقبح الظلم مثلا هو كونه ظلما لأنا عند العلم بكونه ظلما نعلم قبحه وإن لم نعلم شيئا آخر وعند الغفلة عن كونه ظلما لا نعلم قبحه وإن علمنا سائر الأشياء
فثبت أن المقتضي لقبحه ليس إلا هذا الوجه
ومنهم من حاول الاستدلال بأمور
أحدها أن الفعل الذي حكم فيه بالوجوب مثلا لم يختص بما لأجله استحق ثبوت ذلك الحكم وإلا كان تخصيصه بالوجوب دون
سائر الأحكام ودون سائر الأفعال ترجيحا لأحد طرفي الجائز على الآخر لا لمرجح
وثانيها أنه لو لم يكن الحسن والقبح إلا بالشرع لحسن من الله تعالى كل شيء ولو حسن منه كل شيء لحسن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب ولو حسن منه ذلك لما أمكننا أن نميز بين النبي والمتنبيء وذلك يفضي إلى بطلان الشرائع
وثالثها لو حسن من الله تعالى كل شيء لما قبح منه الكذب وعلى هذا فلا يبقى اعتماد على وعده ووعيده
فإن قلت الكلام الأزلي يستحيل أن يكون كذبا
قلت هب أن الأمر كذلك لكن لم لا يجوز أن تكون هذه الكلمات التي نسمعها مخالفة لما عليه الشيء في نفسه وحينئذ يعود الإشكال
ورابعها أن العاقل إذا قيل له إن صدقت أعطيناك دينارا وإن
كذبت أعطيناك أيضا دينارا واستوى عنده الصدق والكذب في جميع الأمور إلا في كونه صدقا وكذبا فإنا نعلم بالضرورة أن العاقل يختار الصدق
ولولا أن الصدق لكونه صدقا حسن وإلا لما كان كذلك
وخامسها أن الحسن والقبح لو لم يكونا معلومين قبل الشرع لاستحال أن يعلما عند ورود الشرع بهما لأنهما إذا لم يكونا معلومين قبل ذلك فعند ورود الشرع بهما يكون واردا بما لا يعقله السامع ولا يتصوره وذلك محال فوجب أن يكونا معلومين قبل ورود الشرع
والجواب عن دعوى الضرورة أنها مسلمة ولكن لا في محل النزاع فإن كل ما كان ملائما للطبع حكموا بحسنه وما كان منافرا للطبع حكموا بقبحه فهذا القدر مسلم فإن ادعيتم أمرا زائدا عليه فلا بد من افادة تصوره
ثم اقامة الدلالة على التصديق به فإن كل ذلك غير مساعد عليه فضلا عن ادعاء العلم الضروري فيه
فإن قلت الظلم ملائم لطبع الظالم ومع ذلك فإنه يجد في صريح العقل قبحه ولأن من خاطب الجماد بالأمر والنهي فإنه لا ينفر طبعه عنه مع أن قبحه معلوم بالضرورة ولأن من أنشأنا قصيدة غراء في شتم الملائكة والأنبياء وكتبها بخط حسن وقرأها بصوت طيب حزين فإنه يميل الطبع إليه وينفر العقل عنه فعلمنا أن نفرة العقل مغايرة لنفرة الطبع
قلت الجواب عن الأول أن الظالم لا يميل طبعه إلى الظلم لأنه لو حكم بحسنه لما قدر على دفع الظلم عن نفسه فالنفرة عن الظلم متمكنة في طبع الظالم والمظلوم إلا أنه إنما رغب فيه لعارض يختص به وهو أخذ المال منه والحكم بحسن الإحسان إنما كان لأن الحكم بحسنه قد يفضي إلى وقوعه وهو ملائم لطبع كل أحد
والحكم بقبح الكذب إنما كان لكونه على خلاف مصلحة العالم وبحسن الصدق لكونه على وفق مصلحة العالم وبحسن انقاذ الغريق لأنه يتضمن حسن الذكر وإن لم يوجد ذلك فلأن من شاهد شخصا من أبناء جنسه في الألم تألم قلبه فإنقاذه منه يستلزم دفع ذلك الألم عن القلب وذلك مما يميل إليه الطبع
وأما مخاطبة الجماد فلا نسلم أن استقباحها يجري مجرى استقباح الظلم والقدر الذي فيه من الاستقباح إنما كان لاتفاق أهل العلم على أن الإنسان لا يجب أن يشتغل إلا بما يفيده فائدة إما عاجلة وإما آجلة
وأما القصيدة المشتملة على الشتم فإنما تستقبح لإفضائها إلى مقابلة أرباب الفضائل بالشتم والاستخفاف وهو على مضادة مصلحة العالم
فظهر أن المرجع في هذه الأشياء إلى ملائمة الطبع ومنافرته ونحن قد ساعدنا على أن الحسن والقبح بهذا المعنى معلوم بالعقل والنزاع في غيره
سلمنا تحقق الحسن والقبح لكن لا نسلم أن المقتضى لقبح الظلم هو كونه ظلما ولم لا يجوز أن يكون المقتضى لقبحه أمرا آخر
قوله العلم بالقبح دائر مع العلم بكونه ظلما وجودا وعدما
قلنا لم قلت إن الدوران العقلي دليل العلية عليه
وما الدليل عليه
ثم إنه منقوض بالمضافين فإن العلم بكل واحد من المضافين دائر مع العلم بالآخر وجودا وعدما مع أنه يمتنع كون أحدهما علة للآخر وتمام تقرير هذا السؤال سيأتي إن شاء الله في كتاب القياس
سلمنا أن الدليل الذي ذكرتموه يقتضي أن يكون قبح الظلم لكونه ظلما لكن معنا ما يدل على فساده وهو أن المفهوم من الظلم اضرار غير مستحق وكونه غير مستحق قيد عدمي والقيد العدمي لا يصلح أن يكون علة للحكم الثابت ولا أن
يكون جزءا للعلة إذ لو جاز استناد الأمر الثبوتي إلى الأمر العدمي لجاز استناد خلق العالم إلى مؤثر عدمي وحينئذ ينسد علينا باب معرفة كون الله تعالى موجدا لأن العدم نفي محض فيستحيل أن يكون مؤثرا
فإن قلت لم لا يجوز أن يكون العدم شرطا لتأثير العلة في المعلول
قلت لأنه إذا فقد هذا العدم لم تكن العلة مؤثرة في المعلول وعند وجوده تصير مؤثرة فيه فكون العلة بحيث تستلزم المعلول وتستعقبه أمر حدث مع حدوث هذا العدم وليس له سبب آخر
سواه فوجب تعليله به فيعود الأمر إلى تعليل الأمر الثبوتي بالأمر العدمي وهو محال
وأما الجواب عما احتجوا به أولا فهو أن رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر إن افتقر إلى المرجح توقف رجحان فاعلية العبد على تاركيته على مرجح غير صادر من جهته وإلا وقع التسلسل ويكون رجحان الفاعلية على التاركية عند حصول ذلك المرجح واجبا وإلا لزم الرجحان لا لمرجح
وإذا كان كذلك لزم الجبر ويلزم من لزوم الجبر القطع ببطلان القبح العقلي
وإن لم يفتقر الرجحان إلى المرجح أصلا فقد اندفعت هذه الشبهة بالكلية
والجواب عما احتجوا به ثانيا أن الاستدلال بالمعجزة على الصدق مبني على مقامين أحدهما أن الله تعالى إنما خلق ذلك المعجز لأجل التصديق
والثاني أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق والقول بالحسن والقبح إنما ينفع في المقام الثاني لا في المقام الأول فلم قلتم إن الله تعالى ما خلق هذا الفعل إلا لغرض التصديق
وتحقيقه أن لو توقف الرجحان على المرجح لزم الجبر وإذا لزم الجبر لزم بطلان القبح العقلي
ولو لم يتوقف على المرجح لجاز أن يقال أن الله تعالى خلق ذلك المعجز لا لغرض أصلا
ثم إن كان ذلك لغرض فلم قلتم إنه لا غرض سوى التصديق
فإن قلت القول بالقبح العقلي يمنع من خلق المعجز على يد الكاذب مطلقا لأن خلقه عند الدعوى يوهم أن المقصود منه التصديق فلو كان المدعي كاذبا لكان ذلك ايهاما لتصديق الكاذب وإنه قبيح والله تعالى لا يفعل القبيح
قلت لم قلت إن الفعل الذي يوهم القبيح ولم يكن موجبا له قبيح وذلك لأن المكلف لما علم أن خلق المعجز عند الدعوى يحتمل أن يكون للتصديق ويحتمل أن يكون لغيره فلو حمله على التصديق قطعا لكان التقصير من المكلف حيث قطع لا في موضع القطع وهذا كإنزال المتشابهات في القرآن فإنه
يوهم القبيح ولكنه لما احتمل سائر الوجوه لم يقبح شيء منها من الله تعالى
فثبت أن الإلزام الذي أوردوه علينا في إحدى المقدمتين وارد عليهم في المقدمة الأخرى وكل ما يجعلونه جوابا عنه في تقرير احدى المقدمتين فهو جوابنا في تقرير المقدمة الأخرى
والجواب عما ذكروه ثالثا أنه وارد عليهم أيضا لأن الكذب قد يكون حسنا وذلك في صورتين إحداهما أن الكافر إذا قصد قتل النبي فاختفى النبي في دار انسان فجاء الكافر وسأل صاحب الدار عن ذلك النبي وعلم صاحب الدار أنه لو أخبره عن مكان النبي أو سكت أو اشتغل بالتعريض لقتله قطعا فها هنا الصدق قبيح والكذب حسن
ثانيهما أن من توعد غيره ظلما وقال إني سأقتلك غدا فلا شك أنه متى لم يفعل ذلك صار هذا الخير كذبا فلو
كان الكذب قبيحا لكان ترك هذه الأشياء مستلزما للقبيح ومستلزم القبيح قبيح فيجب أن يكون ترك هذه الأشياء قبيحا فيكون فعلها حسنا لا محالة وذلك باطل بالاتفاق
فإن قلت الجواب عن الصورة الأولى من وجهين الأول أنا لا نسلم أنه يحسن الكذب هناك ويقبح الصدق فإن الواجب أن يأتي فيه بالمعاريض وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب سلمنا أنه يحسن ذلك ولكن كونه كذبا يقتضي القبح والحكم قد يتخلف عن المقتضى لمانع إلا أن الأصل حصول الحكم عند حصول العلة وهذا هو الجواب أيضا عن الصورة الثانية
قلت الجواب عن الأول أن الخبر إنما يصير من باب
المعاريض باضمار أمر وراء ما دل الظاهر عليه إما بزيادة أو نقصان أو تقييد مطلق أو تخصيص عام مع أنه لا ينبه السامع على أنه نوى ذلك لأنه لو نبهه عليه لما حصل المقصود وإذا جوزتم حسن ذلك لأجل مصلحة تقتضي ذلك لم يمكنكم اجراء خطاب الله تعالى على ظاهره وذلك لا سبيل إليه إلا بأن يقال لا يعرف هذا المعارض لكن عدم العلم بالشيء لا يدل على عدم الشيء
وعن الثاني أن تخلف الأثر العقلي عن المؤثر العقلي محال وإلا كان عدم المانع جزءا من العلة وهو محال ثم إن سلمناه لكن الإلزام عائد عليكم لأنكم لما جوزتم في الجملة تخلف الحكم عن المؤثر لمانع جاز في كل خبر كاذب أن لا يكون قبيحا لأجل أنه وجد مانع يمنع من قبحه وحينئذ لا يحصل القطع
بكونه قبيحا بل غاية ما في الباب أن يحصل الظن بقبحه فقط
والجواب عما ذكروه رابعا أنه إنما ترجح الصدق على الكذب في تلك الصورة لما أن أهل العلم قد اتفقوا على قبح الكذب وحسين الصدق لما أن نظام العالم لا يحصل إلا بذلك والإنسان لما نشأ على هذا الاعتقاد واستمر عليه لا جزم ترجح الصدق عنده على الكذب
فإن قلت أنا أفرض نفسي خالية عن الإلف والعادة والمذهب والاعتقاد ثم أعرض على نفسي عند هذا الفرض هذه القضية فأجدها جازمة بترجيح الصدق على الكذب
قلت هب أنك فرضت نفسك خالية عن هذه العوارض لكن فرض الخلو عن العوارض لا يوجب حصول الخلو عن العوارض
بل لو أني خلقت خاليا عن العوارض ففي ذلك الوقت لا أدري هل كنت أحكم بهذا الحكم أم لا
والجواب عما ذكروه خامسا أن عندنا الموقوف على الشرع ليس هو تصور الحسن والقبح فإني قبل الشرع أتصور ماهية ترتب العقاب والذم على الفعل وعدم هذا الترتب فتصور الحسن والقبح لا يتوقف على الشرع و إنما الموقوف على الشرع هو التصديق به فأين أحدهما من الآخر والله أعلم
وقد جرت عادة أصحابنا أن يتكلموا بعد هذه المسألة في مسألتين أخريين
أحدهما أن شكر المنعم لا يجب عقلا
والثانية أنه لا حكم قبل ورود الشرع
واعلم أنا متى بينا فساد القول بالحسن والقبح العقليين فقد صح مذهبنا في هاتين المسألتين لا محالة
لكن الأصحاب سلموا القول بالحسن والقبح العقليين ثم بينوا أنه بعد تسليم هذين الأصلين لا يصح قول
المعتزلة في هاتين المسألتين
الفصل الثامن
في أن شكر المنعم غير واجب عقلاوقالت المعتزلة بوجوبه عقلا
لنا النص والمعقول
أما النص فقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
وأما المعقول فهو أنه لو وجب لوجب إما لفائدة أو لا لفائدة والقسمان باطلان فالقول بالوجوب باطل
إنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون لفائدة لأن تلك الفائدة إما أن تكون عائدة إلى المشكور أو إلى غيره
والأول باطل لأن الله تعالى منزه عن جلب المنافع ودفع المضار
والثاني باطل لأن الفائدة العائدة إلى الغير إما جلب المنفعة أو دفع المضرة
لا جائز أن يكون ذلك لجلب المنفعة لثلاثة أوجه
الأول أن جلب النفع غير واجب في العقل فما يفضي إليه أولى أن لا يجب
الثاني أنه يمكن خلو الشكر عن جلب النفع لأن الشكر لما كان واجبا فإذن الواجب لا يقتضي شيئا آخر
الثالث أن الله تعالى قادر على إيصال كل المنافع بدون عمل الشكر فيكون توسيط هذا الشكر غير واجب عقلا
ولا جائز أن يكون لدفع المضرة لأنه إما أن يكون لدفع مضرة عاجلة وهو باطل لأن الاشتغال بالشكر مضرة عاجلة فكيف يكون دفعا للمضرة العاجلة
وأما أن يكون لدفع مضرة آجلة وهو باطل أيضا لأن القطع بحصول المضرة عند عدم الشكر إنما يمكن إذا كان المشكور يسره الشكر ويسوءه الكفران فأما من كان منزها عنهما
فاستوى الشكر والكفران بالنسبة إليه فلا يمكن القطع بحصول العقاب على ترك الشكر بل احتمال العقاب على الشكر قائم من وجوه
أحدها أن الشاكر ملك المشكور فإقدامه على تصرف الشكر بغير إذنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة وهذا لا يجوز
وثانيها أن العبد إذا حاول مجازاة المولى على إنعامه عليه استحق التأديب والاشتغال بالشكر اشتغال المجازاة فوجب أن لا يجوز
وثالثها أن من أعطاه الملك العظيم كسرة من الخبز أو قطرة من الماء فاشتغل المنعم عليه في المحافل العظيمة يذكر تلك النعمة وشكرها استحق التأديب وكل نعم الدنيا بالقياس إلى خزانة الله تعالى أقل من تلك الكسرة بالقياس إلى خزانة ذلك الملك فلعل الشاكر يستحق العقاب بسبب شكره
ورابعها لعله لا يهتدي إلى الشكر اللائق فيأتي بغير اللائق فيستحق العقاب
وإنما قلنا إنه لا يمكن أن يجب لا لفائدة لوجهين
الأول أن ذلك عبث وأنه قبيح
والثاني أن المعقول من الوجوب ترتب الذم والعقاب على الترك فإذا فقد ذلك امتنع تحقق الوجوب
فإن قيل لم لا يجوز أن يقال وجب الشكر لمجرد كونه شكرا وذلك لأن وجوب كل شيء لو كان لأجل شيء آخر لزم التسلسل فثبت أنه لا بد وأن ينتهي إلى ما يكون واجبا لذاته
وعندنا الشكر واجب لنفس كونه شكرا كنا أن دفع الضرر عن النفس واجب لنفس كونه دفعا للضرر ولذلك فإن العقلاء يعلمون وجوبه عندما يعلمون كونه شكرا للنعمة و إن لم يعلموا جهة أخرى من جهات الوجوب
نزلنا عن هذا المقام فلم لا يجوز أن يقال وجب الشكر عليه لدفع ضرر الخوف وذلك لأنه لا يجوز أن يكون خالقه طلب منه الشكر على ما أنعم به عليه فلو لم يقدم على الشكر كان مستوجبا للذم والعقاب
أقصى ما في الباب أن يقال كما يجوز هذا يجوز أيضا أن يكون قد منعه من الشكر لتلك الوجوه الأربعة المذكورة في الاستدلال لكن الظن الأول أغلب لأن المشتغل بالخدمة والمواظب على الشكر احسن حالا من المعرض عن الخدمة والمتغافل عن الشكر
وأما تمثيل نعم الله بكسرة الخبز فليس بجيد لأن خلقه العبد واحياءه واقداره وما منحه من كمال العقل وتمكينه من أنواع النعم أعظم من جميع خزائن ملوك الدنيا ثم ما أكرمهم به بعد تمام هذه النعمة من بعثة الرسل اليهم وانزال كتبه عليهم
وقد صرح داود وسليمان عليهما السلام بالشكر في قوله تعالى وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وليس يجب إذا كان تعالى قادرا على أضعاف ما منحه
عبيده من النعم أن يستحقر ما منحه إياهم كما أن الملك إذا أعطى قناطير ذهب فإنه لا يستحقر ذلك لأجل أن خزائنه بقيت مشتملة على أضعاف مضاعفة على ما أعطى
سلمنا أن وجوبه ليس لفائدة زائدة فلم لا يجوز ذلك
قوله أنه عبث والعبث قبيح قلنا إنكم تنكرون القبح العقلي فكيف تمسكتم به في هذا الموضع
سلمنا أن ما ذكرتموه يوجب أن لا يجب الشكر عقلا لكنه يوجب أيضا أن لا يجب شرعا فإنه يقال إنه تعالى لو أوجبه لأوجبه إما لفائدة أو لا لفائدة إلى آخر التقسيم ولما كان ذلك باطلا بالاتفاق فكذا ما ذكرتموه
سلمنا صحة دليلكم ولكنه معارض بوجوه
الأول أن وجوب شكر المنعم مقرر في بدائه العقول وما كان كذلك لم يكن الاستدلال على نقيضه قادحا فيه
الثاني هو أن من وصل إلى طريقين وكان أحدهما آمنا والآخر مخوفا فإن العقل يقضي بسلوك الطريق الآمن دون المخوف وها هنا الاشتغال بالشكر طريق آمن والاعراض عنه مخوف فكان الاشتغال بالشكر أولى
الثالث أنه لو لم يجب الشكر في العقل لم يجب طلب معرفة الله تعالى أيضا لأنه لا فرق في العقل بين البابين
ولو لم يجب طلب معرفة الله تعالى في العقول لزم افحام الرسل والأنبياء لأنهم إذا أظهروا المعجزة قال المدعوون لهم
لا يجب علينا النظر في معجزتكم إلا بالشرع ولا يستقر الشرع إلا بنظرنا في معجزتكم فإذا لم ننظر في معجزتكم ف لا نعرف وجوب ذلك علينا وذلك يقتضي إفحام الرسل
والجواب
قولهم لم لا يجوز أن يجب لنفس كونه شكرا
قلنا قولنا لو وجب الشكر لوجب إما لفائدة أولا لفائدة تقسيم دائر بين النفي والاثبات فلا يحتمل الثالث ألبتة
وأيضاف قولكم إنه وجب لكونه شكرا معناه أن كونه شكرا يقتضي ترتب الذم والعقاب على تركه وهذا داخل فيما ذكرناه فلا يكون هذا قسما زائدا على ما ذكرناه
قوله إنه إنما يجب عليه دفعا لضرر الخوف
قلنا قد بينا أن الخوف حاصل في فعل الشكر كما أنه حاصل في تركه فإذا احتمل الخوف على الأمرين كان البقاء على الترك بحكم استصحاب الحال أولى
فإن لم تثبت أولوية الترك فلا أقل من أن لا يثبت القطع بوجوب الفعل
قوله الاشتغال بالخدمة أولى
قلنا هذا مسلم في حق من يفرح بالخدمة ويتأذى بالإعراض أما في حق من لا يجوز الفرح والغم عليه فمحال
و أيضا فمثل هذا الترجيح لا يفيد إلا الظن
قوله لا يجوز تشبيه نعم الله تعالى بكسرة الخبز
قلنا التشبيه واقع في النسبة لا في المقدار ونحن لا نشك أن جميع نعم الدنيا بالإضافة إلى خزائن الله تعالى أقل من الكسرة بالإضافة إلى ملوك الدنيا
قوله الحكم بكون العبث قبيحا لا يصح إلا مع القول بالقبح العقلي وأنت لا تقول به
قلنا قد ذكرنا أصحابنا إنما تكلموا في هذه المسألة بعد تسليم القبح العقلي ليثبتوا أن كلام المعتزلة ساقط في هذا الفرع مع تسليم ذلك الأصل وإذا كان المقصود ذلك لم يكن ما قالوه قادحا في كلامنا
قوله هذا يقتضي أن لا يحسن ايجاب الشكر من الله تعالى
قلنا غرضنا من الدليل الذي ذكرناه بيان أنه لو صح التحسين والتقبيح العقلي لما أمكن القول بايجاب الشكر لا عقلا ولا شرعا وقد ثبت لنا ذلك
بقي أن يقال فأنتم كيف أوجبتموه شرعا
قلنا لأن من مذهبنا أن أحكام الله تعالى وأفعاله لا تعلل بالأغراض فله بحكم المالكية أن يوجب ما شاء على من شاء من غير فائدة ومنفعة أصلا
وهذا مما لا يتمكن الخصم من القول به فسقط السؤال
أما قوله وجوب الشكر معلوم بالضرورة
قلنا في حق من يسره الشكر ويسوءه الكفران أما في حق من لا يكون كذلك فلا نسلم
فإن قلت بل وجوبه على الاطلاق معلوم بالضرورة وأنت مكابر في ذلك الإنكار
قلت أحلف بالله تعالى و بالايمان التي لا مخارج منها أني راجعت عقلي وذهني وطرحت الهوى والتعصب فلم أجد عقلي قاطعا بذلك في حق من لا يصح عليه النفع والضرر بل ولا ظانا فإن كذبتمونا في ذلك كان ذلك لجاجا ولم تسلموا من المقابلة بمثله أيضا
وأما قوله ترجيح الطريق الآمن على المخوف من لوازم العقل
قلنا نعم لكنا بينا أن كلا الطرفين مخوف فوجب التوقف
قوله إنه يفضي إلى إفحام الأنبياء
قلنا العلم بوجوب الفكر والنظر ليس ضروريا بل نظريا فللمدعو أن يقول إنما يجب علي النظر في معجزتك لو نظرت فعرفت وجوب النظر لكني لا أنظر في أنه هل يجب النظر علي وإذا لم أنظر فيه لا أعرف وجوب النظر في معجزتك فيلزم الإفحام
فإن قلت بل أعرف بضرورة العقل وجوب النظر على
قلت هذا مكابرة لأن العلم بوجوب النظر علي يتوقف على العلم بأن النظر في هذه الأمور الإلهية يفيد العلم وذلك ليس بضروري بل نظري خفي فإن كثيرا من الفلاسفة قالوا إن فكرة العقل تفيد اليقين في الهندسيات والحسابيات فأما في الأمور الإلهية فلا تفيد إلا الظن
ثم بتقدير أن يثبت كونه مفيدا للعلم فإنما يجب الإتيان به لو عرف أن غيره لا يقوم مقامه في إفادة العلم وذلك ما لا سبيل إليه إلا بالنظر الدقيق وإذا كان العلم بوجوب النظر موقوفا على ذينك المقامين النظريين فالموقوف على النظري أولي أن يكون نظريا وإذا كان
كذلك كان العلم بوجوب النظر نظريا لا ضروريا وحينئذ يتحقق الإلزام فكل ما يجعله الخصم جوابا عن ذلك فهو جوابنا عما ذكروه وبالله التوفيق
الفصل التاسع
في حكم الأشياء قبل الشرعانتفاع المكلف بما ينتفع به إما أن يكون اضطراريا كالتنفس في الهواء وغيره وذلك لا بد من القطع بأنه غير ممنوع عنه إلا إذا جوزنا تكليف ما لا يطاق
وإما أن لا يكون اضطراريا كأكل الفواكه وغيرها
فعند المعتزلة البصرية وطائفة من فقهاء الشافعية والحنفية أنها على الإباحة
وعند المعتزلة البغدادية وطائفة من الإمامية وأبي علي بن أبي
هريرة من فقهاء الشافعية أنها على الحظر
وعند أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي وطائفة من الفقهاء أنها على الوقف
وهذا الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم
وتارة بأنا لا ندري هل هناك حكم أم لا
وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر
لنا
أن قبل الشرع ما ورد خطاب الشرع فوجب أن لا يثبت شيء من الأحكام لما ثبت أن هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشرع
أما القائلون بالاباحة فقد تمسكوا بأمور ثلاثة
الأول ما اعتمد عليه أبو الحسين البصري وهو أن تناول الفاكهة مثلا منفعة خالية عن أمارات المفسدة ولا مضرة فيه على المالك فوجب القطع أما أنه منفعة فلا شك فيه وأما أنه
خال عن امارات المفسدة فلأن الكلام فيما إذا كان كذلك
وأما أنه لا ضرر فيه على المالك فظاهر وأما أنه متى كان كذلك حسن الانتفاع به فلأنه يحسن منا الاستظلال بحائط غيرنا والنظر في مرآته والتقاط ما تناثر من حب غلته من غير إذنه إذا خلا عن أمارات المفسدة وإنما حسن ذلك لكونه منفعة خالية عن أمارات المفسدة غير مضرة بالمالك لأن العلم بالحسن دائر مع العلم بهذه الأوصاف وجودا وعدما وذلك دليل العلية
وهذه المعاني قائمة في مسألتنا فوجد الجزم بالحسن
فإن قلت هب أنكم لم تعلموا فيه مفسدة ولكن احتمال مفسدة لا تعلمونها قائم فلم لا يكون ذلك كافيا في القبح
قلت هذا مدفوع من وجهين
الأول أن العبرة في قبح التصرف بالمفسدة المستندة إلى الأمارة فأما المفسدة الخالية عن الأمارة فلا عبرة بها ألا تراهم يلومون من قام من تحت حائط لا ميل فيه لجواز سقوطه ولا يلومونه إذا كان الجدار مائلا ويلومون من امتنع عن أكل طعام شهي لتجويز كونه مسموما من غير أمارة ولا يلومونه على الامتناع عند قيام أمارة فعلمنا أن مجرد الاحتمال لا يمنع
الثاني لو قبح الإقدام لتجويز كونه مفسدة لقبح الاحجام عنه لتجويد كونه مصلحة وفيه وجوب الانفكاك عن كل واحد
منهما وهو تكليف ما لا يطاق
الوجه الثاني في أصل المسألة أن الله تعالى خلق الطعوم في الأجسام مع إمكان أن لا يخلقها فيها وذلك يقتضي أن يكون له تعالى فيها غرض يخصها وإلا كان عبثا ويستحيل أن يعود الغرض إلى الله تعالى لامتناع ذلك عليه فلا بد وأن يكون الغرض عائدا إلى غيره
فأما أن يكون الغرض هو الإضرار أو الإنفاع أو لا هذا ولا ذلك
والأول باطل أما أولا فباتفاق العقلاء وأما ثانيا فلأنه لا يحصل الضرر إلا بإدراكها فإذا كان الضرر مقصودا
والإدراك من لوازم الضرر كان مأذونا فيه لأن لازم المطلوب مطلوب
ولا يجوز أن يكون الغرض أمرا وراء الإضرار والإنفاع لأنه باطل بالاتفاق
فثبت أن الغرض هو الإنفاع وذلك الإنفاع لا يعقل إلا على أحد ثلاثة أوجه
إما بأن يدركها وإما بأن يجتنبها لكون تناولها مفسدة يستحق الثواب باجتنابها وإما بأن يستدل بها
وفي كل ذلك إباحة إدراكها لأنه إنما يستحق الثواب بتجنبها إذا دعت النفس إلى إدراكها وفيه تقدم إدراكها وإنما يستدل بها إذا عرفت والمعرفة بها موقوفة على إدراكها لأن الله تعالى لم يخلق فينا المعرفة بها من دون الإدراك
فصح أنه لا فائدة بها إلا إباحة الانتفاع بها
الوجه الثالث أنه يحسن من العقلاء التنفس في الهواء وأن يدخلوا منه أكثر مما تحتاج إليه الحياة ومن رام أن لا يزيد على قدر ما يحتاج إليه عده العقلاء من المجانين والعلة في حسنه أنه انتفاع لا نعلم فيه مفسدة وهي قائمة في مسألتنا وهذه الدلالة هي عين الدلالة الأولى واستنشاق الهواء مثال ذلك
أما القائلون بالحظر فقد احتجوا بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فوجب أن لا يجوز قياسا على الشاهد
واحتج الفريقان على فساد قولنا إنه لا حكم بوجهين
الأول إن قولكم لا حكم هذا حكم بعدم الحكم والجمع بين إثبات الحكم وعدمه تناقض
والثاني أن هذه التصرفات إما أن تكون ممنوعا عنها فتكون على الحظر أو لا تكون فتكون على الإباحة ولا واسطة بين النفي والإثبات
والجواب عن الأول أن الحكم العقلي في الأصل ممنوع
سلمناه لكن لا نسلم كونه معللا بالوصف المذكور والاعتماد في اثبات العلية على الدوران العقلي قد أبطلناه
وعن الثاني بالقدح فيما ذكروه من التقسيم ثم بالنقض بالمطعومات الموذية المهلكة
وعن حجة أصحاب الحظر بأن الإذن معلوم بدليل العقل كالاستظلال بحائط الغير فلم قلتم إن هذا القياس لا يدل عليه
وعن التناقض بأن نقول أي تناقض في الإخبار عن عدم الإباحة والحظر
وعن الأخير أن مرادنا بالوقف أنا لا نعلم أن الحكم هو الحظر أو الإباحة وإن فسرناه بالعلم بعدم الحكم قلنا هذا القدر ليس إباحة بدليل أنه حاصل في فعل البهيمة مع أنه
لا يسمى مباحا بل المباح هو الذي أعلم فاعله أو دل على أنه لا حرج عليه في الفعل والترك
وإذا بينا أنه لم يوجد هذا الإعلام لا عقلا ولا شرعا لم يكن مباحا والله أعلم
الفصل العاشر
في ضبط أبواب أصول الفقهقد عرفت أن أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها
أما الطرق فإما أن تكون عقلية أو سمعية
أما العقلية فلا مجال لها عندنا في الأحكام لما بينا أنها لا تثبت إلا بالشرع
وأما عند المعتزلة فلها مجال لأن حكم العقل في المنافع الإباحة وفي المضار الحظر
و أما السمعية فإما أن تكون منصوصة أو مستنبطة
أما المنصوص فهو إما قول أو فعل يصدر عمن لا يجوز
الخطأ عليه والذي لا يجوز الخطأ عليه هو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم ومجموع الأمة
والصادر عن الرسول وعن الأمة إما قول أو فعل والفعل لا يدل إلا مع القول فتكون الدلالة القولية مقدمة على الدلالة الفعلية
والدلالة القولية إما أن يكون النظر في ذاتها وهي الأوامر والنواهي وإما في عوارضها إما بحسب متعلقاتها وهي العموم والخصوص أو بحسب كيفية دلالتها وهي المجمل والمبين والنظر في الذات مقدم على النظر في العوارض
فلا جرم باب الأمر والنهي مقدم على باب العموم والخصوص
ثم النظر في العموم والخصوص نظر في متعلق الأمر والنهي والنظر في المجمل والمبين نظر في كيفية تعلق الأمر والنهي بتلك المتعلقات ومتعلق الشيء متقدم على النسبة العارضة بين الشيء وبين متعلقه
فلا جرم قدمنا باب العموم والخصوص على باب المجمل والمبين
وبعد الفراغ منه لا بد من باب الأفعال
ثم هذه الدلائل قد ترد تارة لإثبات الحكم وأخرى لرفعه فلا بد من باب النسخ
وإنما قدمناه على باب الإجماع والقياس لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به وكذا القياس
ثم ذكرنا بعده باب الإجماع
ثم هذه الأقوال والأفعال قد يحتاج إلى التمسك بها من لم يشاهد الرسول صلى الله عليه و سلم ولا أهل الإجماع فلا تصل إليه هذه الأدلة إلا بالنقل فلا بد من البحث عن النقل الذي يفيد العلم والنقل الذي يفيد الظن وهو باب الأخبار
فهذه جملة أبواب أصول الفقه بحسب الدلائل المنصوصة
ولما كان التمسك بالمنصوصات إنما يمكن بواسطة اللغات فلا بد من تقديم باب اللغات على الكل
وأما الدليل المستنبط فهو القياس
فهذه أبواب طرق الفقه
وأما باب كيفية الاستدلال بها فهو باب التراجيح
وأما باب كيفية حال المستدل بها فالذي ينزل حكم الله تعالى به إن كان عالما فلا بد له من الاجتهاد وهو باب شرائط الاجتهاد وأحكام المجتهدين وإن كان عاميا فلا بد له من الاستفتاء وهو باب المفتي والمستفتي
ثم نختم الأبواب بذكر أمور اختلف المجتهدون في كونها طرقا إلى الأحكام الشرعية
فهذه أبواب أصول الفقه
أولها اللغات وثانيها الأمر والنهي وثالثها العموم والخصوص ورابعها المجمل والمبين وخامسها الأفعال وسادسها الناسخ والمنسوخ وسابعها الإجماع وثامنها الأخبار وتاسعها القياس وعاشرها التراجيح وحادي عشرها الاجتهاد وثاني
عشرها الاستفتاء وثالث عشرها الأمور التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي طرق للأحكام الشرعية أم لا
حكم تعلم أصول الفقه
ولنختم هذا الفصل بذكر بحثينالأول أن تحصيل هذا العلم فرض والدليل عليه أن معرفة حكم الله تعالى في الوقائع النازلة بالمكلفين واجبة و لا طريق إلى تحصيلها إلا بهذا العلم وما لا يتأدى الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب
و إنما قلنا إن معرفة حكم الله تعالى واجبة للإجماع على أن المكلف غير مخير بين النفي والإثبات في الوقائع النازلة بل لله تعالى في كل واقعة أو في أكثر الوقائع أحكام معينة على المكلف
وإنما قلنا إنه لا طريق إلى معرفة حكم الله تعالى إلا بهذا العلم لأن المكلف إما أن يكون عاميا أو لا يكون
فإن كان عاميا ففرضه السؤال لقوله فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن لا بد من انتهاء السائلين إلى عالم وإلا لزم الدور أو التسلسل
وعلى جميع التقادير فحكم الله تعالى لا يصير معلوما
وإن كان عالما فالعالم لا يمكنه أن يعرف حكم الله تعالى إلا بطريق لانعقاد الإجماع على أن الحكم بمجرد التشهي غير جائز ولا معنى لأصول الفقه إلا تلك الطرق
فثبت أنه لا سبيل إلى معرفة حكم الله تعالى إلا بأصول الفقه
وأما بيان أن ما لا يتأدى الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا
للمكلف كان واجبا فسيأتي تقريره في باب الأمر إن شاء الله تعالى
البحث الثاني
أنه من فروض الكفايات لأنا سنقيم الدلالة إن شاء الله تعالى في باب المفتي والمستفتي على أنه لا يجب على الناس بأسرهم طلب الأحكام بالدلائل المفصلة بل يجوز الاستفتاء وذلك يدل على أن تحصيل هذا العلم ليس من فروض الأعيان بل من فروض الكفايات والله تعالى أعلم بالصواب
الكلام في اللغات
وفيه تسعة أبواب
الباب الأول
في الأحكام الكلية للغات
اعلم أن البحث إما أن يقع عن ماهية الكلام أو عن كيفية دلالته ولما كانت دلالته وضعية فالبحث إما أن يقع عن الواضع أو عن الموضوع أو عن الموضوع له أو عن الطريق الذي به يعرف الوضع
النظر الأول
في البحث عن ماهية الكلاماعلم أن لفظة الكلام عند المحققين منا تقال بالاشتراك على المعنى القائم بالنفس وعلى الأصوات المتقطعة المسموعة
والمعنى الأول مما لا حاجة في أصول الفقه إلى البحث عنه
إنما الذي نتكلم فيه القسم الثاني
فقال أبو الحسين الكلام هو المنتظم من ا لحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها وربما زيد فيه فقيل إذا صدر عن قادر واحد
أما قولنا المنتظم فاعلم أنه حقيقة في الأجسام لأن النظام هو التأليف وذلك لا يتحقق إلا في الأجسام و لكن الأصوات المتوالية على السمع شبهت بها فأطلق لفظ المولف والمنتظم عليه مجازا
وقولنا من الحروف احترزنا به عن الحرف الواحد فإن أهل اللغة قالوا أقل الكلام حرفان إما ظاهرا وإما في الأصل كقولنا ق ش ع فإنه كان في الأصل
قي و شي و عي ولهذا يرجع في التثنية إليه فيقال قيا عيا إلا أنه أسقط الياء للتخفيف
وقولنا المسموعة احتراز عن حروف الكتابة وقولنا المتميزة احتراز عن أصوات كثير من الطيور
وقولنا المتواضع عليها احتراز عن المهملات
وقولنا إذا صدر عن قادر واحد احتراز عما إذا صدر كل واحد من حروف الكلمة عن قادر آخر نحو أن يتكلم أحدهم بالنون من نصر والثاني بالصاد والثالث بالراء فإن ذلك لا يسمى كلاما
واعلم أن هذا الحد يقتضي أمرين
أحدهما كون الكلمة المفردة كلاما وهو قول الأصوليين
والنحاة أجمعوا على فساد ذلك وقالوا إن لفظ الكلام مخصوص بالجملة المفيدة ونقلوا أيضا فيه نصا عن سيبويه وقول أهل اللغة في المباحث اللغوية راجح على قول غيرهم
الثاني أن قوله أقل الكلام حرفان إما ظاهرا أو في الأصل يشكل بلام التمليك وباء الالصاق وفاء التعقيب فإنها أنواع الحرف الذي هو قسيم الاسم وكل حرف كلمة
وكل كلمة كلام مع أنها غير مركبة
فإن قلت الحركة في الحقيقة حرف فإذا ضمت الحركة إلى الحرف كان المجموع مركبا
قلت هذا على بعده لو قبلناه بقي الإشكال بالياء من غلامي و نون التنوين ولام التعريف فإنها حروف مفردة خالية عن الحركات وهي مفيدة
فالأولى أن نساعد أهل النحو ونقول كل منطوق به دل بالاصطلاح على معنى فهو كلمة
فهذا يتناول الحرف الخالي عن الحركة والحرف المتحرك والمركب من الحروف
وأما الكلام فهو الجملة المفيدة وهي إما الجملة
الاسمية كقولنا زيد قائم أو الفعلية كقولنا قام زيد وإما مركب من جملتين وهي الشرطية كقولك إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود
قال ابن جني الكلام يخرج عن كونه كلاما تارة بالنقصان وتارة بالزيادة
أما بالنقصان فإذا قلت قام زيد ثم أسقطت اسم
زيد واقتصرت على مجرد قولك قام لم يبق كلاما
وأما بالزيادة فإنك إذا أدخلت على تلك الجملة صيغة الشرط حتى صارت هكذا إن قام زيد فإنه لأجل هذه الزيادة خرج عن كونه كلاما لأنه لا يكون مفيدا ما لم يضم اليه غيره
النظر الثاني
في البحث عن الواضع
كون اللفظ مفيدا للمعنى إما أن يكون لذاته أو بالوضع سواء كان الوضع من الله تعالى أو من الناس أو بعضه من الله تعالى وبعضه من الناس فهذه احتمالات أربعة الأول مذهب عباد بن سليمان الصيمري
والثاني وهو القول بالتوقيف مذهب الأشعري وابن فورك
والثالث وهو القول بالاصطلاح مذهب أبي هاشم وأتباعه
والرابع هو القول بأن بعضه توقيفي وبعضه اصطلاحي وفيه قولان منهم من قال ابتداء اللغات يقع بالاصطلاح والباقي لا يمتنع أن يحصل بالتوقيف
ومنهم من عكس الأمر وقال القدر الضروري الذي يقع به الاصطلاحي توقيفي والباقي اصطلاحي وهو قول الأستاذ أبي اسحاق
وأما جمهور المحققين فقد اعترفوا بجواز هذه الأقسام وتوقفوا عن الجزم
والذي يدل على فساد قول عباد بن سليمان أن دلالة الألفاظ لو كانت ذاتية لما اختلفت باختلاف النواحي والأمم ولاهتدى كل انسان إلى كل لغة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم
واحتج عباد بأنه لو لم يكن بين الأسماء والمسميات مناسبة بوجه ما لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحا لأحد طرفي الجائز على الآخر من غير مرجح وهو محال
وإن حصلت بينهما مناسبة فذلك هو المطلوب
والجواب
إن كان الواضع هو الله تعالى كان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين كتخصيص وجود العالم بوقت مقدر دون ما قبله أو ما بعده
وان كان الناس فيحتمل أن يكون السبب خطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت بالبال دون غيره كما قلنا في تخصيص كل شخص بعلم خاص من غير أن يكون بينهما مناسبة
وأما الذي يدل على إمكان الأقسام الثلاثة فهو أن الله تعالى قادر على أن يخلق فيهم علما ضروريا بالألفاظ والمعاني وبأن واضعا وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني
وعلى هذا التقدير تكون اللغات توقيفية
وأيضا فيصح من الواحد منهم أن يضع لفظا لمعنى ثم إنه يعرف الغير ذلك الوضع بالايماء والاشارة ويساعده الآخر عليه ولهذا قيل لو جمع جمع من الأطفال في دار بحيث لا
يسمعون شيئا من اللغات فاذا بلغوا الكبر لا بد و أن يحدثوا فيما بينهم لغة يخاطب بها بعضهم بعضا وبهذا الطريق يتعلم الطفل اللغة من أبويه ويعرف الأخرس غيره ما في ضميره
فثبت إمكان كونها اصطلاحية
واذا ثبت جواز القسمين ثبت جواز القسم الثالث وهو أن يكون البعض توقيفيا والبعض اصطلاحيا
ولما كنا لا نجزم بأحد هذه الثلاثة فذلك يكفي فيه الطعن في طرق القاطعين
احتج القائلون بالتوقيف بالمنقول والمعقول
أما المنقول فمن ثلاثة أوجه
أحدهما قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها دل هذا على أن الأسماء توقيفية واذا ثبت ذلك في الأسماء ثبت أيضا في الأفعال والحروف من ثلاثة أوجه
الأول أنه لا قائل بالفرق
والثاني أن التكلم بالأسماء وحدها متعذر فلا بد
مع تعليم الأسماء من تعليم الأفعال والحروف
والثالث أن الاسم إنما سمي اسما لكونه علامة على مسماه والأفعال والحروف كذلك فهي اسماء أيضا
وأما تخصيص لفظ الاسم ببعض الأقسام فهذا عرف أهل اللغة والنحو
وثانيها أن الله تعالى ذم أقواما على تسميتهم بعض الأشياء من غير توقيف بقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فلو لم يكن ما جعل دالا على غيرها من الاسماء توقيفا لما صح هذا الذم
وثالثها قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم
وألوانكم ولا يجوز أن يكون المراد منه اختلاف تأليفات الألسنة وتركيباتها لأن ذلك في غير الألسن أبلغ وأجمل فلا يكون تخصيص الألسن بالذكر مرادا فبقي أن يكون المراد اختلاف اللغات
وأما المعقول فمن وجهين
أحدهما أن الاصطلاح إنما يكون بأن يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره وذلك لا يعرف إلا بطريق كالألفاظ والكتابة
وكيفما كان فإن ذلك الطريق لا يفيد لذاته فهو إما
بالاصطلاح فيكون الكلام فيه كما في الأول ويلزم التسلسل أو بالتوقيف وهو المطلوب
وثانيها أنها لو كانت بالمواضعة لارتفع الأمان عن الشرع لأنها لعلها على خلاف ما اعتقدناها لأن اللغات قد تبدلت
فان قلت لو وقع ذلك لاشتهر
قلت هذا مبني على أن الواقعة العظيمة يجب اشتهارها وذلك ينتقض بسائر معجزات الرسول وبأمر الاقامة أنها فرادى أو مثناة
أما القائلون بالاصطلاح فقد تمسكوا بالنص والمعقول
أما النص فقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فهذا يقتضي تقدم اللغة على بعثة الرسول فلو كانت اللغة توقيفية والتوقيف لا يحصل إلا بالبعثة لزم الدور وهو محال
وأما المعقول فهو أنها لو كانت توقيفية لكان إما أن يقال إنه تعالى يخلق العلم الضروري بأنه تعالى وضعها لتلك المعاني أو لا يكون كذلك
والأول لا يخلو إما ان يقال إنه تعالى يخلق ذلك العلم في العاقل أو في غير عاقل
وباطل أن يخلقه تعالى في عاقل لأن العلم بأنه تعالى وضع تلك اللفظة لذلك المعنى يتضمن العلم به تعالى فلو كان ذلك العلم ضروريا لكان العلم به تعالى ضروريا لأن العلم بصفة الشيء متى كان ضروريا كان العلم بذاته أولى أن يكون ضروريا ولو كان العلم به تعالى ضروريا لبطل التكليف لكن ذلك باطل لما ثبت أن كل عاقل فإنه يجب أن يكون مكلفا
وباطل أن يخلقه في العاقل لأنه من البعيد أن يصير الانسان غير العاقل عالما بهذه اللغات العجيبة والتركيبات النادرة اللطيفة
وأما الثاني وهو أن لا يخلق الله تعالى العلم الضروري بوضع تلك الألفاظ لتلك المعاني فحينئذ لا يعلم سامعها كونها موضوعة لتلك المعاني إلى بطريق آخر
والكلام فيه كالكلام في الأول فيلزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى الاصطلاح
هذا ملخص ما عول عليه ابن متويه في التذكرة
واحتج الأستاذ أبو اسحاق على قوله بأن الاصطلاح لا يصح إلا بأن يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره فإن عرفه بأمر آخر اصطلاحي لزم التسلسل
فثبت أنه لا بد في أول الأمر من التوقيف
ثم بعد ذلك لا يمتنع أن تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح بل ذلك معلوم بالضرورة ألا ترى أن الناس يحدثون في كل زمان ألفاظا ما كانوا يستعملونها قبل ذلك
فهذا مجموع أدلة الجازمين
والجواب عن التمسك بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أن نقول لم لا يجوز أن يكون المراد من التعليم أنه تعالى
ألهمه الاحتياج إلى هذه الألفاظ وأعطاه من العلوم ما لأجلها قدر على هذا الوضع
وليس لأحد أن يقول التعليم ايجاد العلم بل التعليم فعل صالح لأن يترتب عليه حصول العلم ولذلك يقال علمته فلم يتعلم ولو كان التعليم ايجاد العلم لما صح ذلك
سلمنا أن التعليم ايجاد العلم ولكن العلم الذي يكتسبه العبد مخلوق لله تعالى فالعلم الذي يحصل بعد الاصطلاح بكون من خلق الله تعالى
فقوله تعالى وعلم ولا ينافي كونه بالاصطلاح
سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يكون المراد من الأسماء العلامات والصفات مثل أن يقال إنه تعالى علم آدم عليه
السلام أن الخيل تصلح للكر والفر والجمال للحمل والثيران للزرع وذلك لأن الاسم مشتق من السمة أو من السمو وعلى التقديرين فكل ما يعرف عن ماهية شيء ويكشف عن حقيقته كان اسما له
وأما تخصيص لفظ الاسم بهذه الألفاظ فهذا عرف حادث
سلمنا أن المراد من الأسماء الألفاظ فلم لا يجوز ان يقال إنها كانت موضوعة بالاصطلاح من خلق خلقه الله تعالى قبل آدم عليه السلام فعلمه الله ما تواضع عليه غيره
وعن الثاني
أنهم إنما استحقوا الذم لاطلاقهم لفظ الإله على الصنم
مع اعتقاد تحقق مسمى الإلهية فيها
وعن الثالث
أن اللسان اسم للجارحة المخصوصة وهي غير مرادة بالاجماع فلا بد من المجاز فليسوا بصرفه إلى اللغات أولى منا بصرفه إلى القدرة على اللغات أو إلى مخارج اللغات
وعن الرابع
أنه باطل بتعلم الولد اللغة من والديه فإن ذلك ليس مسبوقا بالتوقيف
سلمناأنه لا بد قبل الاصطلاح من لغة أخرى ليصطلحوا بها على تلك اللغة الثانية فلم لا يجوز أن تكون هذه اللغات التي نتكلم بها الآن توقيفية لاحتمال أن يقال
كان قبل هذه اللغات لغة أخرى وأنها كانت توقيفية ثم إن الناس بتلك اللغة اصطلحوا على وضع هذه اللغات
فإن قلت إذا كان لا بد من الاعتراف بلغة توقيفية فلنعترف بكون هذه اللغات توقيفية ولنسقط من البين تلك الواسطة المجهولة
قلت كلامنا في الجزم وما ذكرته ليس من الجزم في شيء
وعن الخامس
أنه لو وقع التغيير في هذه اللغة لاشتهر
ونقضه بمعجزات الرسول وأن الإقامة فرادى أو مثناة فسيجيء الجواب عنه في باب الأخبار إن شاء الله تعالى
أما الذي احتج به القائلون بالاصطلاح فالجواب عما تمسكوا به أولا
أن الحجة إنما تتم لو لم يحصل التوقيف إلا ببعثة الرسل وذلك ممنوع
وعن الثاني
أنه تعالى خلق فيهم علما ضروريا بأن واضعا وضع هذه الألفاظ بازاء تلك المعاني وإن كان لا يخلق فيهم العلم بأن ذلك الواضع هو الله تعالى
سلمنا أنه تعالى يخلق فيهم العلم بأن ذلك الواضع هو الله تعالى فلم قلت إنه باطل
قوله لأنه ينافي التكليف
قلنا إنه ينافي التكليف بمعرفة الله تعالى ولا ينافي التكليف بسائر الأشياء
سلمنا أنه لا يخلقه في العاقل فلم لا يخلقه في غير العاقل ولم لا يجوز في المجنون أن يعلم بالعلم الضروري بعض الأحكام الدقيقة
فهذا هو الجواب عن وجوه القاطعين ومتى ظهر ضعفها وجب التوقف والله أعلم
النظر الثالث
في البحث عن الموضوع
اعلم أن الانسان الواحد لما خلق بحيث لا يمكنه أن يستقل وحده باصلاح جميع ما يحتاج إليه فلا بد من جمع عظيم ليعين بعضهم بعضا حتى يتم لكل واحد منهم ما يحتاج إليه ف احتاج كل واحد منهم إلى أن يعرف صاحبه ما في نفسه من الحاجاتوذلك التعريف لا بد فيه من طريق وكان يمكنهم أن يضعوا غير الكلام معرفا لما في الضمير كالحركات المخصوصة بالأعضاء المخصوصة معرفات لأصناف الماهيات إلا أنهم وجدوا جعل الأصوات المتقطعة طريقا إلى ذلك أولى من غيرها لوجوه
أحدها أن ادخال الصوت في الوجود أسهل من غيره لأن الصوت إنما يتولد في كيفية مخصوصة في اخراج النفس وذلك أمر ضروري فصرف ذلك الأمر الضروري إلى وجه ينتفع به انتفاعا كليا أولى من تكلف طريق آخر قد يشق على الانسان الإتيان به
وثانيها أن الصوت كما يدخل في الوجود ينقضي فيكون موجودا حال الحاجة ومعدوما حال الاستغناء عنه
وأما سائر الأمور فإنها قد تبقى وربما يقف عليها من لايراد وقوفه عليها
أما الاشارة فإنها قاصرة عن افادة الغرض فإن الشيء ربما كان بحيث لا يمكن الاشارة إليه حسا كذات الله تعالى وصفاته
وأما المعدومات فتعذر الاشارة إليها ظاهر
وأما الأشياء ذوات الجهات فكذلك أيضا لأن الاشارة إذا توجهت إلى محل فيه لون وطعم وحركة لم يكن انصرافها إلى بعضها أولى من البعض
وثالثها أن المعاني التي يحتاج إلى التعبير عنها كثيرة جدا فلو وضعنا لكل واحد منها خاصة لكثرت
العلامات بحيث يعسر ضبطها أو وقوع الاشتراك في أكثر المدلولات وذلك مما يخل بالتفهيم
فلهذه الأسباب وغيرها اتفقوا على اتخاذ الأصوات المتقطعة معرفات للمعاني لا غير
النظر الرابع
في البحث عن الموضوع له
وفيه أبحاث أربعةالأول الأقرب أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه بل ولا يجوز لأن المعاني التي يمكن أن يعقل كل واحد منها غير متناهية فلو وجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه لكان ذلك إما على الانفراد أو على الاشتراك
والأول باطل لأنه يفضي إلى وجود ألفاظ غير متناهية
والثاني باطل أيضا لأن تلك الألفاظ المشتركة إما أن
يوجد فيها ما وضع لمعان غير متناهية أو لا يكون كذلك
والأول باطل لأن الوضع لا يكون إلا بعد التعقل وتعقل أمور غير متناهية على التفصيل محال في حقنا وإذا كان كذلك امتنع منا وقوع التخاطب بمثل ذلك اللفظ
والثاني يقتضي أن تكون مدلولات الألفاظ متناهية لأن الألفاظ إذا كانت متناهية ومدلول كل واحد منها متناه فضم المتناهي إلى المتناهي مرات متناهية لا يفيد إلا التناهي فكان الكل متناهيا فمجموع ما لا نهاية له غير مدلول عليه بالألفاظ
إذا ثبت هذا الأصل فنقول
المعاني على قسمين منها ما تكثر الحاجة إلى التعبير عنه ومنها ما لا يكون كذلك
فالأول لا يجوز خلو اللغة عن وضع اللفظ بازائه لأن الحاجة لما كانت شديدة كانت الدواعي إلى التعبير عنها متوفرة والصوارف عنها زائلة ومع توفر الدواعي إلى التعبير عنها وارتفاع الصوارف يجب الفعل
وأما الأمور التي لا تشتد الحاجة إلى التعبير عنها فإنه يجوز خلو اللغة عن الألفاظ الدالة عليها
البحث الثاني
في أنها ليس الغرض من وضع اللغات أن تفاد بالألفاظ المفردة معانيها
والدليل عليه أن إفادة الألفاظ المفردة لمسمياتها موقوفة على العلم بكونها موضوعة لتلك المسميات المتوقف على العلم بتلك المسميات فلو استفيد العلم بتلك المسميات من تلك الألفاظ
المفردة لزم الدور
بل الغرض من وضع الألفاظ المفردة لمسمياتها تمكين الانسان من تفهم ما يتركب من تلك المسميات بواسطة تركيب تلك الألفاظ المفردة
فان قلت ما ذكرته في المفردات قائم بعينه في المركبات لأن المركب لا يفيد مدلوله إلا عند العلم بكون ذلك اللفظ المركب موضوعا لذلك المدلول وذلك يستدعي سبق العلم بذلك المدلول فلو استفيد العلم بذلك المدلول من ذلك اللفظ المركب لزم الدور
قلت لا نسلم أن الألفاظ المركبة لا تفيد مدلولها إلا عند العلم بكون تلك الألفاظ المركبة موضوعة لذلك المدلول
بيانه أنا متى علمنا كون كل واحد من تلك الألفاظ المفردة موضوعا لتلك المعاني المفردة وعلمنا أيضا كون حركات تلك الألفاظ دالة على النسب المخصوصة لتلك المعاني فاذا توالت الألفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة على السمع ارتسمت تلك المعاني المفردة مع نسبة بعضها إلى بعض في الذهن ومتى حصلت المفردات مع نسبها المخصوصة في الذهن حصل العلم بالمعاني المركبة لا محالة
فظهر أن استفادة العلم بالمعاني المركبة لا تتوقف على العلم بكون تلك الألفاظ المركبة موضوعة لها والله أعلم
البحث الثالث
في أن الألفاظ ما وضعت للدلالة على الموجودات الخارجية بل
وضعت للدلالة على المعاني الذهنية
والدليل عليه أما في الألفاظ المفردة فلأنا إذا رأينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان لكنا ظنناه طيرا سميناه به فإذا ازداد القرب وعرفنا أنه انسان سميناه به فاختلاف الأسامي عند اختلاف الصور الذهنية يدل على أن اللفظ لا دلالة له إلا عليها
وأما في المركبات فلأنك إذا قلت قام زيد فهذا الكلام لا يفيد قيام زيد وإنما يفيد أنك حكمت بقيام زيد وأخبرت عنه ثم إن عرفنا أن ذلك الحكم مبرء عن الخطأ فحينئذ نستدل به على الوجود الخارجي فأما أن يكون اللفظ دالا على ما في الخارج فلا والله أعلم
البحث الرابع
في أن اللفظ المشهور المتداول بين الخاصة والعامة لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي لا يعرفه إلا الخواص مثاله ما يقوله مثبتو الأحوال من المتكلمين أن
الحركة معنى يوجب للذات كونه متحركا
فنقول المعلوم عند الجمهور ليس إلا نفس كونه متحركا فأما أن متحركيته حالة معللة بمعنى وأنها غير واقعة بالقادر فذلك لو صح القول به لما عرفه إلا الأذكياء من الناس بالدلائل الدقيقة ولفظة الحركة لفظة متداولة فيما بين الجمهور من أهل اللغة
وإذا كان كذلك امتنع أن يكون موضوعا لذلك المعنى بل لا مسمى للحركة في وضع اللغة إلا نفس كون الجسم منتقلا لا غير والله أعلم
النظر الخامس
فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناه
لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم كان العلم بشرعنا موقوفا على العلم بهذه الأمور وما لا يتم الواجب المطلق به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب ثم الطريق إلى معرفة لغة العرب ونحوهم وتصريفهم إما العقل وإما النقل أو ما يتركب منهما
أما العقل فلا مجال له في هذه الأشياء لما بينا أنها امور وضعية والأمور الوضعية لا يستقل العقل بإدراكها
وأما النقل فهو إما تواتر أو آحاد والأول يفيد العلم والثاني يفيد الظن
واما ما يتركب من العقل والنقل فهو كما عرفنا بالنقل أنهم جوزوا الاستثناء عن صيغ الجمع وعرفنا بالنقل أيضا أنهم وضعوا الاستثناء لإخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ فحينئذ نعلم بالعقل بواسطة هاتين المقدمتين النقليتين أن صيغة الجمع تفيد الاستغراق
واعلم أن على كل واحد من هذه الطرق الثلاثة اشكالات
أما التواتر فإن الاشكال عليه من وجوه
أحدها أنا نجد الناس مختلفين في معاني الألفاظ التي هي أكثر الألفاظ دورانا على ألسنة المسلمين اختلافا لا يمكن القطع فيه بما هو الحق كلفظة الله تعالى فإن بعضهم زعم أنها ليست عربية بل سريانية والذين جعلوها عربية اختلفوا في أنها من الأسماء المشتقة أو الموضوعة والقائلون بالاشتقاق اختلفوا
اختلافا شديدا وكذا القائلون بكونه موضوعا اختلفوا أيضا اختلافا كبيرا ومن تأمل أدلتهم في تعيين مدلول هذه اللفظة علم أنها متعارضة وأن شيئا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين
وكذلك اختلفوا في الايمان والكفر والصلاة والزكاة حتى إن كثيرا من المحققين في علم الاشتقاق زعموا أن اشتقاق الصلاة من الصلوين وهما عظما الورك ومن المعلوم أن هذا الاشتقاق غريب
وكذلك اختلفوا في صيغ الأوامر والنواهي وصيغ العموم مع شدة اشتهارها وشدة الحاجة اليها اختلافا شديدا
وإذا كان الحال في هذه الألفاظ التي هي أشهر الألفاظ والحاجة إلى استعمالها ماسة جدا كذلك فما ظنك بسائر الألفاظ
وإذا كان كذلك ظهر أن دعوى التواتر في اللغة والنحو متعذرة
فان قلت هب أنه لا يمكن دعوى التواتر في معاني هذه الألفاظ على سبيل التفصيل ولكنا نعلم معانيها في الجملة فنعلم أنهم يطلقون لفظ الله على افله سبحانه وتعالى وان كنا لا نعلم أن مسمى هذا اللفظ أهو الذات أم المعبودية أم القادرية وكذا القول في سائر الألفاظ
قلت حاصل ما ذكرته أنا نعلم إطلاق لفظ الله على
الإله سبحانه وتعالى من غير أن نعلم أن مسمى هذا الاسم ذاته أو كونه معبودا أو كونه قادرا على الاختراع أو كونه ملجأ الخلق أو كونه بحيث تتحير العقول في ادراكه إلى غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ وذلك يفيد نفي القطع بمسماه واذا كان الأمر كذلك في هذه اللفظة مع غاية شهرتها ونهاية الحاجة إلى معرفتها كان الاحتمال فيما عداها أظهر
وثانيها أن من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة فهب أنا علمنا حصول شرائط التواتر في حفاظ اللغة والنحو والتصريف في زماننا هذا فكيف نعلم حصولها في سائر الأزمان
فان قلت الطريق إليه أمران
أحدهما أن الذين شاهدناهم أخبرونا أن الذين أخبروهم بهذه اللغات كانوا موصوفين بالصفات المعتبرة في التواتر وأن
الذين أخبروا من أخبرهم كانوا كذلك إلى أن يتصل النقل بزمان الرسول صلى الله عليه و سلم
وثانيهما أن هذه الألفاظ لو لم تكن موضوعة لهذه المعاني ثم وضعها واضع لهذه المعاني لاشتهر ذلك ولعرف فإن ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله
قلت أما الأول فغير صحيح لأن كل واحد منا حين سمع لغة مخصوصة من انسان فإنه لم يسمع منه أنه سمع من أهل التواتر وأن الذين اسمعوا كل واحد من مسمعيه سمعوها أيضا من أهل التواتر إلى أن يتصل
ذلك بزمان الرسول صلى الله عليه و سلم بل تحرير هذه الدعوى على هذا الوجه مما لا يفهمه كثير من الأدباء فكيف يدعى أنهم علموه بالضرورة
بل الغاية القصوى في راوي اللغة أن يسنده إلى كتاب مصحح أو إلى استاذ متقن ومعلوم أن ذلك لا يفيد اليقين
وأما الثاني فضعيف أيضا أما أولا فلأن ذلك الاشتهار إنما يجب في الأمور العظيمة ووضع اللفظة المعينة بإزاء المعنى المعين ليس من الأمور العظيمة التي يجب اشهارها
وأما ثانيا فلأن ذلك ينتقض ب ما أنا نرى أكثر العرب في زماننا هذا يتكلمون بألفاظ مختلة واعرابات فاسدة مع أنا لا نعلم واضع تلك الألفاظ المختلة ولا زمان وضعها وينتقض أيضا بالألفاظ العرفية فإنها نقلت عن موضوعاتها الأصلية مع أنا لا نعلم المغير ولا زمان التغيير فكذا ها هنا
سلمنا أنه يجب أن يشتهر ذلك لكن لا نسلم أنه لم يشتهر فإنه قد اشتهر بل بلغ مبلغ التواتر أن هذه اللغات إنما أخذت عن جمع مخصوصين كالخليل وأبي عمرو بن العلاء والاصمعي
وأبي عمرو الشيباني وأضرابهم ولا شك أن هؤلاء ما كانوا معصومين ولا كانوا بالغين حد التواتر وإذا كان كذلك لم يحصل القطع واليقين بقولهم
أقصى ما في الباب أن يقال نعلم قطعا استحالة كون هذه اللغات بأسرها منقولة على سبيل الكذب إلا أنا نسلم ذلك
ونقطع بأن فيها ما هو صدق قطعا لكن كل لفظة عيناها فإنه لا يمكننا القطع بأنها من قبيل ما نقل صدقا أو كذبا وحينئذ لا يبقى القطع في لفظ معين أصلا
هذا هو الاشكال على من ادعى التواتر في نقل اللغات
أما الآحاد فالاشكال عليها من وجوه
أحدها أن رواية الآحاد لا تفيد إلا الظن ومعرفة القرآن والأخبار مبنية على معرفة اللغة والنحو والتصريف والمبني على المظنون مظنون فوجب أن لا يحصل القطع بشيء من مدلولات القرآن والاخبار وذلك خلاف الاجماع
وثانيها أن رواية الآحاد لا تفيد الظن إلا إذا سلمت عن القدح وهؤلاء الرواة مجرحون
بيانه أن أجل الكتب المصنفة في النحو واللغة كتاب سيبويه وكتاب العين
أما كتاب سيبويه فقدح الكوفيين فيه وفي صاحبه أظهر من الشمس
وأيضا فالمبرد كان من أجل البصريين وهو قد أورد كتابا في القدح فيه
وأما كتاب العين فقد أطبق الجمهور من أهل اللغة على القدح فيه
وأيضا فإن ابن جني أورد بابا في كتاب الخصائص في قدح أكابر الأدباء بعضهم في بعض وتكذيب بعضهم بعضا
وطول في ذلك وأفرد بابا آخر في أن لغة أهل الوبر أصح من لغة أهل المدر وغرضه من ذلك القدح في الكوفيين وأفرد بابا آخر في كلمات الغريب لا يعلم أحد اتى بها إلا ابن أحمر الباهلي
وروي عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها ولم يسبقا إليها وعلى نحو هذا قال المازني ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم
وأيضا فالأصمعي كان منسوبا إلى الخلاعة ومشهورا أنه كان يزيد في اللغة ما لم يكن منها
والعجب من الأصوليين أنهم أقاموا الدلالة على أن خبر الواحد حجة في الشرع ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة وكان هذا أولى لأن اثبات اللغة كالأصل للتمسك بخبر الواحد وبتقدير أن يقيموا الدلالة على ذلك فكان من الواجب عليهم أن يبحثوا عن أحوال رواة اللغاة والنحو وأن يتفحصوا عن اسباب جرحهم وتعديلهم كما فعلوا ذلك في رواة الأخبار لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة إليه فإن اللغة والنحو يجريان مجرى الأصل للاستدلال بالنصوص
وثالثهما أن رواية الراوي إنما تقبل إذا سلمت عن المعارض
وهاهنا روايات دالة على أن هذه اللغة تتطرق إليها الزيادة والنقصان
أما الزيادة فلما نقلنا عن رؤبة وأبيه من الزيادات وكذلك عن الأصمعي والمازني
وأما النقصان فلما روى ابن جني باسناده عن ابن سيرين عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه فجاء الاسلام فتشاغلت عنه
العرب بالجهاد وغزو فارس والروم وغفلت عن الشعر وروايته فلما كثر الاسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في الأمصار راجعوا رواية الشعر فلم يؤولوا فيه إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب وقد هلك من العرب من هلك فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم أكثره
وروى ابن جني أيضا باسناده عن يونس بن حبيب عن أبي عمرو ابن العلاء أنه قال ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير
قال ابن جني فهذا ما نراه وقد روي في معناه كثير وذلك يدل على تنقل الأحوال بهذه اللغة واعتراض الأحداث عليها وكثرة تغيرها
وأيضا فالصحابة مع شدة عنايتهم بأمر الدين واجتهادهم في ضبط أحواله عجزوا عن ضبط الأمور التي شاهدوها في كل يوم خمس مرات وهو كون الإقامة فرادى أو مثناة والجهر بالقراءة ورفع اليدين فاذا كان الأمر في هذه الأشياء الظاهرة كذلك فما ظنك باللغات وكيفية الاعرابات مع قلة وقعها في القلوب ومع ما أنه لم يشتغل بتحصيلها وتدوينها محصل إلا بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين
وأما ما يتركب من العقل والنقل فالاعتراض عليه أن الاستدلال بالمقدمتين النقليتين على النتيجة لا يصح إلا إذا ثبت أن المناقضة غير جائزة على الواضع وهذا إنما يثبت اذا ثبت أن الواضع هو الله تعالى وقد بينا أن ذلك غير معلوم
فان قلت الناس قد أجمعوا على صحة هذا الطريق لأنهم لا يثبتون شيئا من مباحث علم النحو والتصريف إلا بهذا الطريق والاجماع حجة
قلت اثبات الاجماع من فروع هذه القاعدة لأن اثبات الاجماع سمعي فلا بد فيه من اثبات الدلائل السمعية
والدليل السمعي لا يصح إلا بعد ثبوت اللغة والنحو والتصريف فالإجماع فرع هذا الأصل فلو أثبتنا هذا الأصل بالاجماع لزم الدور وهو محال فهذا تمام الإشكال
والجواب
أن اللغة والنحو على قسمين
أحدهما المتداول المشهور والعلم الضروري حاصل بأنها في الأزمنة الماضية كانت موضوعة لهذه المعاني فإننا نجد أنفسنا جازمة بأن لفظ السماء والأرض كانتا مستعملتين في زمان الرسول صلى الله عليه و سلم في هذين المسميين ونجد
الشكوك التي ذكروها جارية مجرى شبه السوفسطائية القادحة في المحسوسات التي لا تستحق الجواب
وثانيهما الألفاظ الغريبة والطريق إلى معرفتها الآحاد إذا عرفت هذا فنقول أكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم الأول فلا جرم قامت الحجة به
وأما القسم الثاني فقليل جدا وما كان كذلك فإنا لا نتمسك به في المسائل القطعية ونتمسك به في الظنيات ونثبت
وجوب العمل بالظن بالاجماع ونثبت الاجماع بآية واردة بلغات معلومة لا مظنونة وبهذا الطريق يزول الإشكال والله أعلم
الباب الثاني
في تقسيم الألفاظ
وهو من وجهينالتقسيم الأول
اللفظ إما أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى تمام مسماهأو بالنسبة إلى ما يكون داخلا في المسمى من حيث هو كذلك أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمى من حيث هو كذلك
فالأول هو المطابقة
والثاني التضمن
والثالث الالتزام
تنبيهات
الأول الدلالة الوضعية هي دلالة المطابقة وأما الباقيتان
فعقليتان لأن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من المسمى إلى لازمه
ولازمه إن كان داخلا في المسمى فهو التضمن وان كان خارجا فهو الالتزام
الثاني إنما قلنا في التضمن إنه دلالة اللفظ على جزء المسمى من حيث هو كذلك احترازا عن دلالة اللفظ على جزء المسمى بالمطابقة على سبيل الاشتراك وكذلك القول في الالتزام
الثالث دلالة الالتزام لا يعتبر فيها اللزوم الخارجي لأن الجوهر والعرض متلازمان ولا يستعمل اللفظ الدال على
أحدهما في الآخر والضدان متنافيان وقد يستعمل اللفظ الدال على احدهما في الآخر كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها بل المعتبر اللزوم الذهني ظاهرا ثم هذا اللزوم شرط لا موجب
ولنرجع إلى التقسيم فنقول
اللفظ الدال بالمطابقة إما أن لا يدل شيء من أجزائه على شيء حين هو جزؤه وهو المفرد كالأبكم
وإما أن يدل كل واحد من أجزائه على شيء حين هو جزؤه وهو المركب
وأما أن يدل أحد جزئيه دون الآخر وهو غير واقع لأنه
يكون ضما لمهمل إلى مستعمل وهو غير مفيد
أما المفرد فيمكن تقسيمه على ثلاثة أوجه
الأول أن المفرد إما أن يمنع نفس تصور معناه من الشركة وهو الجزئي
أو لا يمنع وهو الكلي
ثم الماهية الكلية إما أن تكون تمام الماهية أو جزئها أن خارجا عنها
والأول هو المقول في جواب ما هو
والثاني هو الذاتي
والثالث هو العرضي
أما الماهية فإما أن تكون ماهية واحد أو ماهية أشياء
و الأول هو الماهية بحسب الخصوصية
اما الثاني فتلك الأشياء لا بدو أن يخالف كل واحد منها صاحبه في التعين
فإما أن يحصل مع ذلك مخالفة بعضها بعضا في شيء من الذاتيات أو لا يحصل
فإن كان الأول فتمام القدر المشترك بينها من الأمور الداخلة فيها هو تمام الماهية المشتركة لأن ما هو أعم منه لا يكون تمام المشترك وما هو أخص منه لا يكون مشتركا وما يساويه فإن ساواه في الماهية فهو هو لا غيره
وإن ساواه في اللزوم دون المفهوم لم يكن هو تمام القدر المشترك
وان كان الثاني كان تمام القدر المشترك بينهما هو تمام ماهية كل منهما بعينه إذ لو كان لكل واحد منهما ذاتي آخر وراء القدر المشترك كانت المخالفة بينهما لا بالتعين فقط بل وبالذاتيات وقد فرض أنه لا مخالفة في الذاتيات هذا خلف
وأما الذاتي فهو إما أن يكون تمام الجزء المشترك وهو الجنس
أو تمام الجزء الذي يميزه عما يشاركه في الجنس وهو الفصل
أو المجموع الحاصل منهما وهو النوع
وإما أن لا يكون كذلك فيكون ذلك جزء الجزء وهو إما جنس الجنس أو جنس الفصل أو فصل الجنس أو فصل الفصل
ثم إن الأجناس تترتب متصاعدة وتنتهي في الارتقاء إلى جنس لا جنس فوقه وهو جنس الأجناس
والأنواع تترتب متنازلة إلى نوع لا نوع تحته وهو نوع الأنواع
و أما الوصف الخارج عن الماهية فتقسيمه على وجهين
الأول أن ذلك الخارجي إما ان يكون لازما للماهية أو للوجود أو لا يلزم واحد منهما
ثم لازم كل واحد من القسمين قد يكون بوسط وقد يكون بغير وسط والذي يكون بوسط ينتهي إلى غير ذي وسط وإلا لزم الدور أو التسلسل
وغير اللازم قد يكون سريع الزوال وقد يكون بطيئه
الثاني أن الوصف الخارجي إما أن يعتبر من حيث إنه مختص بنوع واحد لا يوجد في غيره وهو الخاصة
أو من حيث إنه موجود فيه وفي غيره وهو العرض العام
وهذا التقسيم وإن كان بالحقيقة في المعاني لكنه عظيم النفع في الألفاظ
التقسيم الثاني
للفظ المفردوهو أنه إما أن يكون معناه مستقلا بالمعلومية أو لا يكون والثاني هو الحرف
والأول إما أن يكون اللفظ الدال عليه دالا على الزمان المعين لمعناه وهو الفعل
أو لا يدل وهو الاسم
ثم الاسم تقسيمه من وجهين
الأول أن الاسم ان كان اسما للجزئي فإن كان مضمرا فهو المضمرات وإن كان مظهرا فهو العلم
وان كان اسما للكلي فهو إما ان يكون اسما لنفس الماهية كلفظ السواد وهو المسمى باسم الجنس في اصطلاح النحاة
أو لموصوفية أمر ما بصفة وهو الاسم المشتق كلفظ الضارب فإن مفهومه أنه شيء ما مجهول بحسب دلالة هذا اللفظ لكن علم منه أنه موصوف بصفة الضرب
الثاني أن الاسم هو الذي يدل على معنى ولا يدل على زمانه المعين
وهو على أقسام ثلاثة فإن المسمى قد يكون نفس الزمان كلفظ الزمان واليوم والغد
وقد يكون أحد أجزائه الزمان كالاصطباح والاغتباق ولهذا يتطرق اليه التصريف
وقد لا يكون زمانا ولا مركبا من الزمان كالسواد وأمثاله
التقسيم الثالث
للفظ المفردوهو إما أن يكون اللفظ والمعنى واحدا أو يتكثران أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى أو بالعكس
أما القسم الأول فالمسمى إن كان نفس تصوره مانعا من الشركة ومظهرا فهو العلم
وإن لم يمنع فحصول ذلك المسمى في تلك المواضع إن كان بالسوية فهو المتواطئ
أولا بالسوية فهو المشكك كالوجود الذي ثبوت
مسماه للواجب أولى من ثبوته للممكن
أما إذا تكثرت الألفاظ والمعاني فهي المتباينة سواء تباينت المسميات بذواتها أو كان بعضها صفة للبعض كالسيف والصارم أو صفة للصفة كالناطق والفصيح
وأما إذا تكثرت الألفاظ واتحد المعنى فهو الألفاظ المترادفة سواء كانت من لغة واحدة أم من لغات كثيرة
وأما إذا اتحد اللفظ وتكثر المعنى فهذا اللفظ إما أن يكون قد وضع أولا لمعنى ثم نقل عنه إلى معنى آخر أو وضع لهما معا
أما الأول فإما أن يكون ذلك النقل لا لمناسبة بين المنقول إليه
والمنقول عنه وهو المرتجل
أو لمناسبة وحينئذ إما أن تكون دلالة اللفظ بعد النقل على المنقول إليه أقوى م دلالته على المنقول عنه أو لا تكون
فان كان الأول سمي اللفظ بالنسبة إلى المنقول إليه لفظا منقولا
ثم الناقل إن كان هو الشارع سمي لفظا شرعيا
أو أهل العرف فيسمى لفظا عرفيا والعرف إما أن يكون عاما كلفظ الدابة أو خاصا كالاصطلاحات التي لكل طائفة من أهل العلم
وأما إن لم تكن دلالته على المنقول إليه أقوى من دلالته على
المنقول عنه سمي ذلك اللفظ بالنسبة إلى الوضع الأول حقيقة
وبالنسبة إلى الثاني مجازا
ثم جهات النقل كثيرة من جملتها المشابهة وهي المسمى بالمستعار خاصة
و أما إذا كان اللفظ موضوعا للمعنيين جميعا فإما أن تكون إرادة ذلك اللفظ لهما على السوية أو لا تكون على السوية
فإن كانت على السوية سميت اللفظة بالنسبة اليهما معا مشتركا
وبالنسبة إلى كل واحد منهما مجملا لأن كون اللفظ موضوعا لهذا وحده ولذاك وحده معلوم فكان مشتركا من هذا الوجه
وأما إن كان المراد منه هذا أو ذاك غير معلوم فلا جرم كان مجملا من هذا الوجه
وأما إن كانت دلالة اللفظ على أحد مفهوميه أقوى سمي اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهرا
وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا
تنبيه الأقسام الثلاثة الأول مشتركة في عدم الاشتراك فهي نصوص
وأما الرابع فينقسم إلى ما إفادته لأحد مفهوميه أرجح من افادته للثاني وهو الظاهر
وإلى ما لا يكون كذلك وهو الذي يكون على السوية وهو المجمل
أو مرجوحا وهو المؤول
ف النص والظاهر يشتركان في الرجحان إلا أن النص راجح مانع من النقيض
فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم فهو جنس
لنوعين النص والظاهر
والذي لا يقتضي الرجحان فهو المتشابه وهو جنس لنوعين المجمل والمؤول
أما المركب فنقول الحاجة إلى اللفظ المركب كما تقدم للإفهام
فالقول المفهم إما أن يفيد طلب شيء إفادة أولية أو لا يفيده
فإن كان الأول فإما أن يفيد طلب ذكر ماهية الشيء وهو الاستفهام
أو طلب التحصيل وهو إن كان على وجه الاستعلاء فهو الأمر
وان كان على وجه الخضوع فهو السؤال
وان كان على وجه التساوي فهو الالتماس
وكذلك القول في طلب الامتناع
وأما القول المفهم الذي لا يفيد طلب شيء إفادة اولية
فإما أن يحتمل التصديق والتكذيب وهو الخبر أو لا يكون كذلك وهو مثل التمني والترجي والقسم والنداء ويسمى هذا القسم بالتنبيه تمييزا له عن غيره
وأنواع جنس التنبيه معلومة بالاستقراء لا بالحصر هذا كله تقسيم المطابقة
أما تقسيم دلالة الالتزام فنقول المعنى المستفاد من دلالة الالتزام إما أن يكون مستفادا من معاني الألفاظ المفردة أو من حال تركيبها
والأول قسمان لأن المعنى المدلول عليه بالالتزام إما أن يكون
شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة أو تابعا له
فان كان الأول فهو المسمى بدلالة الاقتضاء
ثم تلك الشرطية قد تكون عقلية كقوله صلى الله عليه و سلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فإن العقل دل على أن هذا المعنى لا يصح إلا إذا أضمرنا فيه الحم الشرعي
وقد تكون شرعية كقوله والله لأعتقن هذا العبد فإنه يلزمه تحصيل الملك لأنه لا يمكنه الوفاء بقوله شرعا إلا بعد ذلك
وأما إن كان تابعا لتركيبها فإما أن يكون من مكملات ذلك المعنى أو لا يكون
فالأول كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب عند من لا يثبته بالقياس
وأما الثاني فإما أن يكون المدلول عليه بالالتزام ثبوتيا أو عدميا
أما الأول فكقوله تعالى فالآن باشروهن ومد ذلك إلى غاية تبين الخيط الأبيض فيلزم فيمن أصبح جنبا أن لا يفسد صومه وإلا وجب أن يحرم الوطء في آخر جزء من الليل بقدر ما يقع الغسل فيه
وما الثاني فهو أن تخصيص الشيء بالذكر هل يدل على نفيه عما عداه والله أعلم
التقسيم الثاني
للألفاظاللفظ الدال على معنى إما أن يكون مدلوله لفظا أو لا يكون
والثاني بمعزل عن اعتبارنا
والذي مدلوله لفظ فإما أن يكون لفظا مفردا أو مركبا
وكلاهما إما أن يكون دالا على معنى أو ليس بدال على معنى
فهذه اربعة
أحدها اللفظ الدال على لفظ مفرد دال على معنى مفرد وهو لفظ الكلمة وأنواعها وأصنافها فإن لفظ الكلمة بتناول لفظ الاسم وهو لفظ مفرد ويتناول لفظ الرجل وهو لفظ مفرد دال على معنى مفرد وكذا القول في جميع أسماء الألفاظ كالقول والكلام والأمر والنهي والعام والخاص وأمثالها
وثانيها اللفظ الدال على لفظ مركب موضوع لمعنى مركب وهو كلفظ الخبر فإنه يتناول قولك زيد قائم وهو لفظ مركب دال على معنى مركب
وثالثها اللفظ الدال على لفظ مفرد لم يوضع لمعنى وهو الحرف المعجم فإنه يتناول كل واحد من آحاد الحروف وتلك الحروف لا تفيد شيئا
فإن قلت أليس أنهم قالوا لفظ الألف اسم لتلك المدة
قلت ليس المراد من قولي الحرف لا يفيد شيئا إلا نفس تلك المدة وكذا القول في سائر الحروف
ورابعها اللفظ الدال على لفظ مركب لم يوضع لمعنى والأشبه أنه غير موجود لأن التركيب إنما يصار إليه لغرض الإفادة فحيث لا إفادة فلا تركيب
واعلم أن في البحث عن ماهية الاسم والفعل والحرف دقائق غامضة ذكرناها في كتاب المحرر في دقائق النحو والله أعلم
الباب الثالث
في الأسماء المشتقة
والنظر في ماهية الاسم المشتق وفي أحكامهأما الماهية فقال الميداني رحمه الله الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر واركانه أربعة
أحدها اسم موضوع لمعنى
وثانيها شيء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى
وثالثها مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الأصلية
ورابعها تغيير يلحق الاسم في حرف فقط أو حركة فقط أو فيهما معا
وكل واحد من الأقسام الثلاثة فإما ان يكون بالزيادة أو بالنقصان أو بهما معا فهذه تسعة أقسام
أحدها زيادة الحركة وثانيها زيادة الحرف وثالثها زيادتهما معا ورابعها نقصان الحركة وخامسها نقصان الحرف وسادسها نقصانهما معا وسابعها زيادة الحرف مع نقصان الحركة وثامنها زيادة الحركة مع نقصان الحرف وتاسعها أن تزاد فيه حركة وحرف وتنقص منه أيضا حركة وحرف
فهذه الأقسام الممكنة وعلى اللغوي طلب امثلة ما وجد
منها
أما الأحكام فنذكرها في مسائل
المسألة الأولى
أن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه خلافا لأبي علي وأبي هاشم فإن العالم والقادر والحي اسماء مشتقة من العلم والقدرة والحياة
ثم إنهما يطلقان هذه الأسماء على الله تعالى وينكران حصول العلم والقدرة والحياة لله تعالى لأن المسمى بهذه الأسامي هي المعاني التي توجب العالمية والقادرية والحيية وهذه المعاني غير ثابتة لله تعالى فلا يكون لله تعالى علم وقدرة وحياة مع أنه عالم قادر حي
وأما أبو الحسين فإنه لا يتقرر معه هذا الخلاف لأن المسمى عنده بالقدرة نفس القادرية وبالعلم العالمية وهذه الأحكام حاصلة لله تعالى فيكون لله تعالى علم وقدرة
لنا
أن المشتق مركب والمشتق منه مفرد والمركب بدون المفرد غير معقول
المسألة الثانية
اختلفوا في أن بقاء وجه الاشتقاق هل هو شرط لصدق اسم المشتق والأقرب أنه ليس بشرط خلافا لأبي علي بن سيناء من الفلاسفة وأبي هاشم من المعتزلة
لنا
أن بعد انقضاء الضرب يصدق عليه أنه ليس بضارب واذا صدق ذلك وجب أن لا يصدق عليه أنه ضارب
بيان الأول أنه يصدق عليه أنه ليس بضارب في هذه الحال وقولنا ليس بضارب جزء من قولنا ليس بضارب في
هذه الحال ومتى صدق الكل صدق كل واحد من أجزائه فإذن صدق عليه أنه ليس بضارب
و بيان الثاني أنه لما صدق عليه ذلك وجب أن لا يصدق عليه أنه ضارب لأن قولنا ضارب يناقضه في العرف ليس بضارب بدليل أن من قال فلان ضارب فمن أراد تكذيبه وإبطال قوله قال إنه ليس بضارب ولولا أنه نقيض الأول وإلا لما استعملوه لنقض الأول ولما ثبت كونهما موضوعين لمفهومين متناقضين وقد صدق أحدهما فوجب أن لا يصدق الآخر
فإن قيل لا نسلم أنه يصدق عليه بعد انقضاء الضرب أنه ليس بضارب
قوله لأنه يصدق عليه أنه ليس بضارب في هذه الحال ومتى صدق عليه ذلك صدق عليه أنه ليس بضارب
قلنا حكم الشيء وحده يجوز أن يكون مخالفا لحكمه مع غيره فلا يلزم من صدق قولنا ليس بضارب في الحال صدق قولنا ليس بضارب
سلمنا أنه يصدق عليه أنه ليس بضارب فلم لا يصدق عليه أنه ضارب بيانه أن قولنا فلان ضارب فلان ليس بضارب ما لم نعتبر فيه اتحاد الوقت لم يتناقضا ولا يجوز ايراد أحدهما لتكذيب الآخر
سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على قولكم لكنه معارض بوجوه
الأول أن الضارب من حصل له الضرب و هذا المفهوم أعم من قولنا حصل له الضرب في الحال أو في الماضي لأنه يمكن تقسيمه اليهما ومورد القسمة مشترك بين القسمين ولا يلزم من نفي الخاص نفي المشترك فإذن لا يلزم من نفي الضاربية في الحال نفي الضاربية مطلقا
الثاني أن أهل اللغة اتفقوا على أن اسم الفاعل إذا كان في تقدير الماضي لا يعمل عمل الفعل ولولا أن اسم الفاعل يصح اطلاقه لفعل وجد في الماضي وإلا لكان هذا الكلام لغوا
الثالث أنه لو كان حصول المشتق منه شرطا في كون الاسم المشتق حقيقة لما كان اسم المتكلم والمخبر و اليوم و الأمس وما يجري مجراها حقيقة في شيء أصلا واللازم باطل فالملزوم مثله
بيان الملازمة أن الكلام اسم لمجموع الحروف المتوالية لا لكل واحد منها ومجموع تلك الحروف لا وجود له أصلا بل الموجود منه أبدا ليس إلا الحرف الواحد فلو كان شرط
كون الاسم المشتق حقيقة حصول المشتق منه لوجب أن لا يصير هذا الاسم المشتق حقيقة ألبتة
فإن قلت لم لا يجوز أن يقال الكلام اسم لكل واحد من تلك الحروف
سلمنا أنه ليس كذلك فلم لا يجوز أن يقال حصول المشتق مه شرط في كون المشتق حقيقة إذا كان ممكن الحصول فأما إذا لم يكن كذلك فلا
أو نقول شرط كون المشتق حقيقة حصول المشتق منه إما لمجموعه أو لأجزائه وهاهنا إن امتنع أن يكون للمجموع وجود لكنه لا يمتنع ذلك للآحاد
أو نقول لم لا يجوز أن يقال هذه الألفاظ ليست حقائق في شيء من المسميات أصلا
قلت
الجواب عن الأول
أن ذلك باطل باجماع أهل اللغة و أيضا فالالزام عائد في لفظ الخبر فإنه لا شك في أن كل واحد من حروف الخبر ليس خبرا وكذلك كل واحد من أجزاء الشهر والسنة ليس بشهر ولا سنة
وعن الثاني
أن أحدا من الأمة لم يقل بهذا الفرق فيكون باطلا
وعن الثالث أن هذه الألفاظ مستعملة وكل مستعمل فإنه إما أن يكون حقيقة أو مجازا وكل مجاز فله حقيقة فإذن هذه الألفاظ حقائق في بعض الأشياء وقد علم بالضرورة أنها ليست حقائق فيما
عدا هذه المعاني فهي حقائق فيها
الرابع الايمان مفسر إما بالتصديق أو العمل أو الاقرار أو مجموعها
والشخص حين ما لا يكون مباشرا لشيء من هذه الأشياء الثلاثة يسمى مؤمنا حقيقة فلولا أن حصول ما منه الاشتقاق ليس شرطا لصدق المشتق وإلا لما كان كذلك
والجواب
قوله يجوز أن يختلف حال الشيء بسبب الانفراد والتركيب
قلنا مدلول الألفاظ المركبة ليس إلا المركب الحاصل من المفردات التي هي مدلولات الألفاظ المفردة
قوله وحدة الزمان معتبرة في تحقق التناقض
قلنا هذا لا نزاع فيه لكنا ندعي أن قولنا ضارب يفيد الزمان المعين وهو الحاضر بدليل ما ذكرنا أن إحدى اللفظتين مستعملة في رفع الأخرى أما أولا فلأنا نعلم بالضرورة من أهل اللغة أنهم متى حاولوا تكذيب المتلفظ باحدى اللفظتين لا يذكرون إلا اللفظة الأخرى ويكتفون بذكر كل واحدة منهما عند محاولة تكذيب الأخرى ولولا اقتضاء كل واحدة منهما للزمان المعين وإلا لما حصل التكاذب
وأما الثانية فلأن كلمة ليس موضوعة للسلب فإذا قلنا ليس بضارب فلا بد وأن يفيد سلب ما فهم من قولنا
ضارب وإلا لم تكن لفظة ليس مستعملة للسلب
وإذا ثبت أن كل واحدة من هاتين اللفظتين موضوعة لرفع مقتضى الأخرى وجب تناولهما لذلك الزمان المعين وإلا لم يحصل التكاذب
ثم لا نزاع في أن ذلك الزمان ليس هو الماضي ولا المستقبل فتعين أن يكون الحاضر
قوله في المعارضة الأولى ثبوت الضرب له أعم من ثبوته له في الحاضر أو الماضي بدليل صحة التقسيم إليهما
قلنا كما يمكن تقسيمه إلى الماضي والحاضر يمكن تقسيمه إلى المستقبل فإنه يمكن أن يقال ثبوت الضرب له
أعم من ثبوته له في الحال أو في المستقبل فإن كان ما ذكرته يقتضي كون الضارب حقيقة لمن حصل له الضرب في الماضي فليكن حقيقة لمن سيوجد الضرب منه في المستقبل وإن لم يوجد ألبتة لا في الحاضر ولا في الماضي فإنه باطل بالاتفاق
قوله ثانيا إن أهل اللغة قالوا اسم الفاعل إذا أفاد الفعل الماضي لا يعمل عمل الفعل
قلنا وقد قالوا أيضا إذا أفاد الفعل المستقبل عمل عمل الفعل فيلزم أن يكون الاسم المشتق حقيقة فيما سيوجد فيه المشتق منه ولا شك في فساده
قوله ثالثا يلزم أن لا يكون اسم المخبر حقيقة أصلا
قلنا المعتبر عندنا حصوله بتمامه إن أمكن أو حصول آخر جزء من أجزائه ودعوى الاجماع على فساد هذا التفصيل ممنوعة
قوله رابعا الشخص يسمى مؤمنا وإن لم يكن مشتغلا في الحال بمسمى الايمان
قلنا لا نسلم أن ذلك الاطلاق حقيقة
والدليل عليه أنه لا يجوز أن يقال في أكابر الصحابة إنهم كفرة لأجل كفر كان موجودا قبل إيمانهم ولا لليقظان إنه نائم لأجل نوم كان موجودا قبل ذلك والله أعلم
المسألة الثالثة اختلفوا في أن المعنى القائم بالشيء هل يجب أن يشتق له منه اسم
والحق والتفصيل فإن المعاني التي لا أسماء لها مثل أنواع الروائح والآلام فلا شك أن ذلك غير حاصل فيها وأما التي لها اسماء ففيها بحثان
أحدهما أنه هل يجب أن يشتق لمحالها منها أسماء
الظاهر من مذهب المتكلمين منا أن ذلك واجب فإن المعتزلة لما قالت إن الله تعالى يخلق كلامه في جسم قال أصحابنا لهم لو كان كذلك لوجب أن يشتق لذلك المحل اسم المتكلم من ذلك الكلام
وعند المعتزلة أن ذلك غير واجب
وثانيهما أنه إذا لم يشتق لمحله منه اسم فهل يجوز أن يشتق لغير ذلك المحل منه اسم
فعند أصحابنا لا
وعند المعتزلة نعم لأن الله تعالى يسمى متكلما بذلك الكلام
و استدلت المعتزلة لقولهم في الموضعين بأن القتل والضرب و الجرح قائم بالمقتول والمضروب والمجروح ثم إن المقتول لا يسمى قاتلا فإذن محل المشتق منه لم يحصل له اسم الفاعل وحصل ذلك الاسم لغير محله
وأجيبوا عنه بأن الجرح ليس عبارة عن الأمر الحاصل في المجروح بل عن تأثير قدرة القادر فيه وذلك التأثير حكم حاصل للفاعل وكذا القول في القتل
وأجابت المعتزلة عنه بأنه لا معنى لتأثير القدرة في المقدور إلا وقوع المقدور إذ لو كان التأثير أمرا زائدا لكان
إما أن يكون قديما وهو محال لأن تأثير الشيء في الشيء نسبة بينهما فلا يعقل ثبوته عند عدم واحد منهما أو محدثا فيفتقر إلى تأثير آخر فيلزم التسلسل
والذي يحسم مادة الإشكال أن الله تعالى خالق العالم واسم الخالق مشتق من الخلق والخلق نفس المخلوق والمخلوق غير قائم بذات الله تعالى
والدليل على أن الخلق عين المخلوق أنه لو كان غيره لكان إن كان قديما لزم قدم العالم وإن كان محدثا لزم التسلسل
ومما يدل على أنه ليس من شرط المشتق منه قيامه بمن له الاشتقاق أن المفهوم من الاسم المشتق ليس إلا أنه ذو ذلك المشتق منه ولفظ ذو لا يقتضي الحلول
ولأنه لفظة اللابن والتامر والمكي والمدني والحداد مشتقة من أمور يمتنع قيامها بمن له الاشتقاق
المسألة الرابعة
مفهوم الأسود شيء ما له السواد فأما حقيقة ذلك
الشيء فخارج عن المفهوم فإن علم علم بطريق الالتزام
والذي يدل عليه أنك تقول الأسود جسم فلو كان مفهوم الأسود أنه جسم ذو سواد لتنزل ذلك منزلة ما يقال الجسم ذو السواد يجب أن يكون جسما والله أعلم بالصواب
الباب الرابع
في أحكام الترادف والتوكيد
الألفاظ المترادفة هي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار واحدواحترزنا بقولنا المفردة عن الرسم والحد
وبقولنا باعتبار واحد عن اللفظتين إذا دلا على شيء واحد باعتبار صفتين كصارم والمهند أو باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق فإنهما من المتباينة
واعلم أن الفرق بين المترادف والمؤكد أن المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت أصلا
وأما المؤكد فانه لا يفيد عين فائدة المؤكد بل يفيد تقويته
والفرق بينه وبين التابع كقولنا شيطان ليطان أن التابع وحده لا يفيد بل شرط كونه مفيدا تقدم الأول عليه
أما الأحكام ففي مسائل
المسألة الأولى في إثباته
من الناس من أنكره وزعم أن الذي يظن أنه من المترادفات فهو من المتباينات التي تكون لتباين الصفات أو لتباين الموصوف مع الصفات
والكلام معهم إما في الجواز وهو معلوم بالضرورة أو في الوقوع وهو إما في لغتين وهو أيضا معلوم بالضرورة
أو في لغة واحدة وهو مثل الأسد والليث والحنطة والقمح
والتعسفات التي يذكرها الاشتقاقيون في دفع ذلك مما لا يشهد بصحتها عقل ولا نقل فوجب تركها عليهم
المسألة الثانية في الداعي إلى الترادف
الأسماء المترادفة إما أن تحصل من واضع أو من واضعين
أما الأول فيشبه أن يكون هو السبب الأقلي وفيه سببان
الأول التسهيل والإقدار على الفصاحة لأنه قد يمتنع وزن
البيت وقافيته مع بعض أسماء الشيء ويصح مع الاسم الآخر وربما حصل رعاية السجع والمقلوب والمجنس وسائر أصناف البديع مع بعض أسماء الشيء دون البعض
الثاني التمكين من تأدية المقصود باحدى العبارتين عند نسيان الأخرى
وأما الثاني فيشبه أن يكون هو السبب الأكثري وهو اصطلاح إحدى القبيلتين على اسم لشيء غير الذي اصطلحت القبيلة الأخرى عليه ثم اشتهار الوضعين بعد ذلك
ومن الناس من قال الأصل عدم الترادف لوجهين
الأول أنه يخل بالفهم التام لاحتمال أن يكون المعلوم لكل واحد من المتخاطبين غير الاسم الذي يعلمه الآخر فعند
التخاطب لا يعلم كل واحد منهما مراد الآخر فيحتاج كل واحد منهما إلى حفظ تلك الألفاظ حذرا عن هذا المحذور فتزداد المشقة
الثاني أنه يتضمن تعريف المعرف وهو خلاف الأصل
المسألة الثالثة في أنه هل تجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر أم لا
الأظهر في أول النظر ذلك لأن المترادفين لا بد وأن يفيد كل واحد منهما عين فائدة الآخر فالمعنى لما صح أن يضم إلى معنى حينما يكون مدلولا لأحد اللفظين لا بد وأن يبقى بتلك الصفة حال كونه مدلولا للفظ الثاني لأن صحة الصم من عوارض المعاني لا من عوارض الألفاظ
والحق أن ذلك غير واجب لأن صحة الضم قد تكون من
عوارض الألفاظ لأن المعنى الذي يعبر عنه في العربية بلفظ من يعبر عنه في الفارسية بلفظ آخر فإذا قلت خرجت من الدار استقام الكلام ولو أبدلت صيغة من وحدها بمرادفها من الفارسية لم يجز
فهذا الامتناع ما جاء من قبل المعاني بل من قبل الألفاظ
وإذا عقل ذلك في لغتين فلم لا يجوز مثله في لغة واحدة
المسألة الرابعة إذا كان أحد المترادفين أظهر كان الجلي بالنسبة إلى الخفي شرحا له وربما انعكس الأمر بالنسبة إلى قوم آخرين
وزعم كثير من المتكلمين أنه لا معنى للحد إلا ذلك
فقالوا الحد تبديل لفظ خفي بلفظ أوضح منه تفهيما للسائل
وليس الأمر كما ذكروه على الاطلاق بل الماهية المفردة إذا حاولنا تعريفها بدلالة المطابقة لم يكن إلا على الوجه الذي ذكروه
المسألة الخامسة
في التأكيد وأحكامه
وفيه أبحاث
الأول التأكيد هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ آخر
الثاني الشيء إما أن يؤكد بنفسه أو بغيره فالأول كقوله عليه الصلاة و السلام والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا
والثاني على ثلاثة أقسام
فإن لفظة التأكيد إما ان يختص بها المفرد وهو لفظ النفس و العين أو المثنى وهو كلا وكلتا
أو الجمع وهو أجمعون أكتعون أبصعون والكل وهو أم الباب
وقد يكون داخلا على الجمل مقدما عليها كصيغة إن وما يجري مجراها
الثالث في حسن استعماله والخلاف فيه مع الملاحدة الطاعنين في القرآن والنزاع إما أن يقع في جوازه عقلا أو في وقوعه
أما الجواز فهو معلوم بالضرورة لأن التأكيد يدل على شدة اهتمام القائل بذلك الكلام
وأما الوقوع فاستقراء اللغات بأسرها يدل عليه
واعلم أن التأكيد وان كان حسنا إلا أنه متى أمكن حمل الكلام على فائدة زائدة وجب صرفه إليها
الرابع في فوائد التأكيد وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها في باب العموم عند استدلال الواقفية بحسن التأكيد على الاشتراك والله أعلم
الباب الخامس
في الاشتراك
اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلكفقولنا الموضوع لحقيقتين مختلفتين احترزنا به عن الأسماء المفردة
وقولنا وضعا أولا احترزنا به عما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز
وقولنا من حيث هما كذلك احترزنا به عما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز
وقولنا من حيث هما كذلك احترزنا به عن اللفظ المتواطيء فإنه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث
إنها مختلفة بل من حيث إنها مشتركة في معنى واحد
المسألة الأولى
في بيان امكانه ووجوده
وجود اللفظ المشترك إما أن يكون واجبا أو ممتنعا أو جائزا وقال بكل واحد من هذه الأقسام قائل
أما القائلون بالوجوب فقد احتجوا بأمرين
الأول أن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية والمتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك
و إنما قلنا إن الألفاظ متناهية لأنها مركبة من الحروف المتناهية والمركب من المتناهي متناهي
وإنما قلنا إن المعاني غير متناهية لأن الأعداد أحد أنواع المعاني وهي غير متناهية
وأما أن المتناهي إذا وزع على غير المتناهي حصل الاشتراك فهو معلوم بالضرورة
الثاني أن الألفاظ العامة كالوجود والشيء لا بد منها في اللغات
ثم قد ثبت أن وجود كل شيء نفس ماهيته فيكون كل شيء مخالفا لوجود الآخر فيكون قول الموجود عليها بالاشتراك
والجواب عن الأول بعد تسليم المقدمتين الباطلتين أن نقول الأمور التي يقصدها المسمون بالتسمية متناهية فإنهم لا يشرعون في أن يسموا كل واحد من الأمور التي لا نهاية لها فإن ذلك مما لا يخطر ببالهم فكيف يقصدون تسميتها بل لا يقصدون إلا إلى تسمية أمور متناهية ويمكن أن يكون لكل واحد منها اسم مفرد
وأيضا فكل واحد من هذه الألفاظ المتناهية إن دل على معان متناهية لم يكن جميع الألفاظ المتناهية دالا على معان غير متناهية لأن المتناهي إذا ضوعف مرات متناهية كان الكل متناهيا
وإن دل كل واحد منها أو بعضها على معان غير متناهية فالقول به مكابرة
وعن الثاني أنا لا نسلم أن الألفاظ العامة ضرورية في اللغات وإن سلمنا ذلك لا نسلم أن الوجود غير مشترك في المعنى
وإن سلمنا لكن لم لا يجوز اشتراك الموجودات بأسرها في حكم واحد سوى الوجود وهو المسمى بتلك اللفظ العامة
أما القائلون بالامتناع فقد قالوا
المخاطبة باللفظ المشترك لا تفيد فهم المقصود على سبيل التمام وما يكون كذلك كان منشأ للمفاسد على ما سيأتي تقريره في مسألة أن الأصل عدم الاشتراك وما يكون منشأ للمفاسد وجب أن لا يكون
والجواب
لا نزاع في أنه لا يحصل الفهم التام من سماع اللفظ المشترك لكن هذا القدر لا يوجب نفيه لأن أسماء الأجناس غير دالة على أحوال تلك المسميات لا نفيا ولا اثباتا والأسماء المشتقة لا تدل على تعين الموصوفات ألبتة ولم يلزم من ذلك جزم القول بأنها غير موضوعة فكذا هاهنا
واذا بطل هذان القولان فنحن نبين الامكان أولا ثم الوقوع ثانيا
أما بيان الامكان فمن وجهين
الأول أن المواضعة تابعة لأغراض المتكلم وقد يكون للانسان غرض في تعريف غيره شيئا على التفصيل وقد يكون غرضه تعريف ذلك الشيء على الاجمال بحيث يكون ذكر التفصيل سببا للمفسدة كما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للكافر الذي سأله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقت ذهابهما إلى الغار من هو فقال رجل يهديني السبيل ولأنه ربما لا يكون المتكلم واثقا بصحة الشيء على التعيين إلا أنه يكون واثقا بصحة وجود أحدهما لا محالة
فحينئذ يطلق اللفظ المشترك لئلا يكذب ولا يكذب ولا يظهر جهله بذلك فإن أي معنى يصح فله أن يقول إنه كان مرادي
الثاني أن ما ذكروه من المفاسد لو صح فإنما يقدح في أن يضع الواضع لفظا لمعنيين على سبيل الاشتراك لكنه يجوز أن يوجد المشترك بطريق آخر وهو أن تضع قبيلة اسما لشيء وقبيلة أخرى ذلك الاسم لشيء آخر ثم يشيع الوضعان ويخفى كونه موضوعا للمعنيين من جهة القبيلتين
و أما الوقوع فمن الناس من قال إن كل ما يظن مشتركا فهو إما أن يكون متواطئا أو يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر كالعين فإنه وضع أولا للجارحة المخصوصة ثم نقل إلى الدينار لإنه في الغرة والصفاء كتلك
الجارحة وإلى الشمس لأنها في الصفاء والضياء كتلك الجارحة وإلى الماء لوجود المعنيين فيه
وعندنا أن كل ذلك ممكن والأغلب على الظن وقوع المشترك
والدليل عليه أنا إذا سمعنا القرء لم نفهم أحد المعنيين من غير تعيين بل بقي الذهن مترددا ولو كان اللفظ متواطئا أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر لما كان كذلك
فإن قلت لم لا يجوز أن يقال كان حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر ثم خفي ذلك
قلت أحكام اللغات لا تنتهي إلى القطع المانع من الاحتمالات البعيدة وما ذكرتموه لا ينفي كونه حقيقة فيهما الآن وهو المقصود والله أعلم
المسألة الثانية
في أقسام اللفظ المشترك
المفهومان إما أن يكونا متباينين كالطهر والحيض المسميين بالقرء أولا يكونا متباينين بل يكون بينهما تعلق وحينئذ لا يخلو إما أن يكون أحدهما جزءا من الآخر أو لا يكون
فالأول مثل ما إذا سمي معنى عام باسم وسمي معنى خاص تحته بذلك الاسم فوقوع الاسم عليهما والحالة هذه يكون بالاشتراك مثل الممكن اذا قيل لغير الممتنع و قيل لغير الضروري فإن غير الممتنع أعم من غير الضروري فإذا قيل الممكن عليهما فهو بالاشتراك
وأيضا فقوله على الخاص وحده قول بالاشتراك أيضا بالنظر إلى ما فيه من المفهومين المختلفين
وأما إن لم يكن احدهما جزءا من الآخر فلا بد وأن يكون أحدهما صفة للآخر وهو كما إذا سمي شخص أسود اللون
بالأسود فان قول الأسود عليه من حيث إنه لقب ومن حيث إنه مشتق بالاشتراك ثم إذا نسبت ذلك الشخص إلى القار فإن اعتبرت لونه كان الأسود مقولا عليه وعلى القار بالتواطؤ وإن اعتبرت اسمه كان الاسود مقولا عليه وعلى القار بالاشتراك
دقيقة لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين عدم الشيء وثبوته لأن اللفظ لا بد وأن يكون بحال متى أطلق أفاد شيئا وإلا كان عبثا والمشترك بين النفي والاثبات لا يفيد إلا التردد بين النفي والاثبات وهذا معلوم لكل أحد
المسألة الثالثة
في سبب وقوع الاشتراك
السبب الأكثري هو أن تضع كل واحدة من
القبيلتين تلك اللفظة لمسمى آخر ثم يشتهر الوضعان فيحصل الاشتراك
والأقلي هو أن يضعه واضع واحد لمعنيين ليكون المتكلم متمكنا من التكلم بالمجمل وقد سبق في الفصل السالف أن التكلم بالكلام المجمل من مقاصد العقلاء ومصالحهم
وأما السبب الذي يعرف به كون اللفظ مشتركا فذلك إما الضرورة وهو ان يسمع تصريح أهل اللغة به
وإما النظر وذلك أنا سنذكر إن شاء الله تعالى الطرق
الدالة على كون اللفظة حقيقة في مسماها فاذا وجدت تلك الطرق في اللفظة الواحدة بالنسبة إلى معنيين مختلفين حكمنا بالاشتراك
ومن الناس من ذكر فيه طريقين آخرين
أحدهما أن حسن الاستفهام يدل على الاشتراك لأن الاستفهام عبارة عن طلب الفهم وطلب الشيء حال حصوله محال
والفهم إنما لا يكون حاصلا لو كان اللفظ مترددا بين المعنيين
الثاني قالوا استعمال الفظ في معنيين ظاهرا يدل على كونه حقيقة فيهما وذلك يقتضي الاشتراك
واعلم أنا سنبين ان شاء الله تعالى في باب العموم أن هذين الطريقين لا يدلان على الاشتراك
المسألة الرابعة
في أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع
وذهب الشافعي والقاضي أبو بكر رضي الله عنهما إلى جوازه وهو قول الجبائي والقاضي
عبد الجبار بن أحمد
وذهب آخرون إلى امتناعه وهو قول أبي هاشم وأبي الحسين البصري والكرخي
ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد
ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع وهو المختار
وقبل الخوض في الدليل لا بد من مقدمة وهي أنه ليس يلزم من كون اللفظ موضوعا لمعنيين على البدل أن يكون موضوعا لهما جميعا وذلك لأنا نعلم بالضرورة المغايرة بين المجموع وبين كل واحد من أفراده ولا يلزم أن يكون المجموع مساويا لكل واحد من أفراده في جميع الأحكام فلا يلزم من كون كل واحد من الشيئين مسمى باسم كون مجموعهما مسمى به
اذا ثبتت هذه المقدمة فالدليل على ما قلنا أن الواضع إذا وضع لفظا لمفهومين على الانفراد فإما أن يكون قد وضعه مع ذلك لمجموعهما أو ما وضعه لهما
فإن قلنا إنه ما وضعه للمجموع فاستعماله لافادة المجموع استعمال اللفظ في غير ما وضع له وإنه غير جائز
وإن قلنا إنه وضعه للمجموع فلا يخلو إما أن يستعمل لإفادة المجموع وحده أو لإفادته مع إفادة الأفراد
فان كان الأول لم يكن اللفظ إلا لأحد مفهوماته لأن الواضع إن كان وضعه بازاء أمور ثلاثة على البدل وأحدها ذلك المجموع فاستعمال اللفظ فيه وحده لا يكون استعمالا للفظ في كل واحد من مفهوماته
فان قلت إنه يستعمل في إفادة المجموع والأفراد على الجمع فهو محال لأن افادته للمجموع معناه
أن الاكتفاء لا يحصل إلا بهما وافادته للمفرد معناه أنه يحصل الاكتفاء بكل واحد منهما وحده وذلك جمع بين النقيضين وهو محال
فثبت أن اللفظ المشترك من حيث إنه مشترك لا يمكن استعماله في إفادة مفهوماته على سبيل الجمع
و احتج المجوزون بأمور
أحدها أن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ثم إن الله تعالى أراد بهذه اللفظة كلا معنييها في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
و ثانيها قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب
أراد بالسجود ها هنا الخضوع لأنه هو المقصود من الدواب وأراد به أيضا وضع الجبهة على الأرض لأن تخصيص كثير من الناس بالسجود دون ما عداهم ممن حق عليه العذاب مع استوائهم في السجود بمعنى الخشوع يدل على أن الذي خصوا به من السجود هو وضع الجبهة على الأرض فقد صار المعنيان مرادين
وثالثها قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إذا أراد به الحيض والطهر لأن المرأة إذا كانت من أهل
الاجتهاد فالله تعالى أراد منها الاعتداد بكل واحد منهما بدلا عن الآخر بشرط أن يؤدي اجتهادها إليه أو إلى الآخر
ورابعها قال سيبويه قول القائل لغيره الويل لك دعاء وخبر فجعله مفيدا لكلا الأمرين
والجواب عن هذه الوجوه بأسرها
أن ما ذكروه لو صح لدل على أن هذه الألفاظ كما هي موضوعة للآحاد فهي موضوعة للجمع وإلا لكان الله تعالى قد استعمل اللفظ في غير مفهومه وهو غير جائز
وعلى هذا التقدير يكون استعماله لإفادة الجمع استعمالا له في
إفادة أحد موضوعاته لا في إفادة الكل على ما بيناه والله أعلم
فرعان
الأول
بعض من أنكر استعمال المفرد المشترك في جميع مفهوماته جوز ذلك في لفظ الجمع
أما في جانب الاثبات فكقوله للمرأة اعتدي بالأقراء
والحق أنه لا يجوز لأن قوله اعتدي بالأقراء معناه اعتدي بقرء وقرء وقرء وإذا لم يصح أن يفاد بلفظ القرء كلا المدلولين لم يصح ذلك أيضا في الجمع الذي لا يفيد الا عين فائدة الافراد
و أما في جانب النفي فكذلك ايضا وفيه احتمال
لأنا إنما منعناه من إفادة المعنيين في جانب الإثبات لما قلنا إن الواضع ما وضعه لهما جميعا
و أما في جانب النفي فلم يقم دليل قاطع على أن الواضع ما استعلمه في إفادة نفيهما جميعا
ويمكن أن يجاب عنه بأن النفي لا يفيد إلا رفع مقتضى الاثبات فإذا لم يفد في جانب الإثبات إلا أمرا واحدا لم يرتفع عند حرف النفي إلا المعنى الواحد
فأما إن أريد حمله على أن المراد منه لا تعتدي بما هو مسمى الأقراء فحينئذ يكون كون الحيض والطهر مسمى بالقرء وصفا معقولا مشتركا بينهما فيكون
اللفظ على هذا التقدير متواطئا لا مشتركا
الثاني
أنا لو جوزنا أن يفاد باللفظ المشترك جميع معانيه فإنه لا يجب ذلك
ونقل عن الشافعي رضي الله عنه والقاضي أبي بكر أنهما قالا المشترك إذا تجرد عن القرائن المخصصة وجب حمله على جميع معانيه وفيه نظر لأنه إن لم يكن موضوعا للمجموع فلا يجوز استعماله فيه وإن كان موضوعا له فهو أيضا موضوع لكل واحد من الأفراد واللفظ دائر بين كل واحد من الفردين وبين المجموع فيكون الجزم بإفادته للمجموع دون كل واحد من الفردين ترجيحا لأحد الجائزين على الآخر من غير مرجح وهو محال
فإن قلت حمله على المجموع أحوط فيكون الأخذ به واجبا
قلت القول بالاحتياط سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى
المسألة الخامسة
في أن الأصل عدم الاشتراك
ونعنى به أن اللفظ متى دار بين الاشتراك وعدمه كان الأغلب على الظن عدم الاشتراك
ويدل عليه وجوه
أحدها أن احتمال الاشتراك لو كان مساويا لاحتمال الانفراد لما حصل التفاهم بين أرباب اللسان حالة التخاطب في أغلب الأحوال من غير استكشاف وقد علمنا حصول ذلك فكان الغالب حصول احتمال الانفراد
وثانيها لو لم يكن الاشتراك مرجوحا لما بقيت الأدلة السمعية مفيدة ظنا فضلا عن اليقين لاحتمال أن يقال إن تلك الألفاظ مشتركة بين ما ظهر لنا منها وبين غيره
وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون المراد غير ما ظهر لنا
وحينئذ لا يبقى التمسك بالقرآن والأخبار مفيدا للظن فضلا عن العلم
وثالثها أن الاستقراء دل على أن الكلمات في الأكثر مفردة لا مشتركة والكثرة تفيد ظن الرجحان
فان قلت لا نسلم أن الكلمات في الأكثر مفردة لأن الكلمة إما حرف أو فعل أو اسم
أما الحرف فكتب النحو شاهدة بأنه مشترك
وأما الفعل فهو إما الماضي أو المستقبل أو الأمر
أما الماضي والمستقبل فهما مشتركان لأنهما تارة يستعملان في الخبر وأخرى في الدعاء ولأن صيغة المضارع مشتركة
بين الحال والاستقبال وأما صيغة إفعل فالقول بأنها مشتركة بين الوجوب والندب مشهور
وأما الأسماء ففيها اشتراك كثير
فإذا ضممنا اليها الأفعال والحروف كانت الغلبة للاشتراك
قلت الأصل في الألفاظ الأسماء والاشتراك نادر فيها بدليل أنه لو كان الاشتراك أغلب لما حصل فهم غرض المتكلم في الأكثر ولما لم يكن كذلك علمنا أن الغالب عدم الاشتراك
ورابعها أن الاشتراك يخل بفهم القائل والسامع وذلك يقتضي أن لا يكون موضوعا
بيان أنه يقتضي الخلل في الفهم
أما في حق السامع فمن وجهين
الأول أن الغرض من الكلام حصول الفهم وهو غير حاصل في المشترك لتردد الذهن بين مفهوماته
الثاني أن سامع اللفظ المشترك ربما يتعذر عليه الاستكشاف إما لأنه يهاب المتكلم أو لأنه يستنكف عن السؤال وإذا لم يستكشف فربما حمله على غير المراد فيقع في الجهل ثم ربما ذكره لغيره فيصير ذلك سببا لجهل جمع كثير ولهذا قال أصحاب المنطق إن السبب الأعظم في وقوع الأغلاط حصول اللفظ المشترك
وأما في حق القائل فلأن الانسان إذا تلفظ باللفظ المشترك احتاج في تفسيره إلى أن يذكره باسمه المفرد فيقع تلفظه باللفظ المشترك عبثا ولأنه ربما ظن أن السامع
متنبه للقرينة الدالة على تعيين المراد مع أن السامع لم يتنبه له فيحصل الضرر كمن قال لعبده أعط الفقير عينا على ظن أنه يفهم أن مراده الماء ثم إنه يعطيه الذهب فيتضرر السيد به
فثبت بهذه الوجوه أن الاشتراك منشأ للمفاسد فهذه المفاسد إن لم تقتض امتناع الوضع فلا أقل من اقتضاء المرجوحية
وخامسها أن الانسان مضطر في بقائه إلى استعمال المفردات ولا حاجة به إلى المشترك فيكون المفرد أغلب في الوجود وفي الظن
بيان الحاجة إلى المفردات أن الإنسان لا يستقل بتكميل مهمات معيشته بدون الاستعانة بغيره والاستعانة بالغير لا تتم إلا
بإطلاع الغير على حاجته وقد عرفت أن ذلك لا يحصل إلا بالألفاظ وذلك التعريف لا يحصل إلا بالألفاظ المفردة
وإنما قلنا إن الحاجة إلى المشترك غير ضرورية لأنهم إن احتاجوا إلى التعريف الاجمالي أمكنهم ذكر تلك المفردات مع لفظ الترديد وحينئذ يحصل المطلوب في اللفظ المشترك
وإذا ظهرت المقدمتان ثبت رجحان المفرد على المشترك في الوجود وفي الذهن وهو المطلوب والله أعلم
المسألة السادسة
فيما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك
اللفظ المشترك إما أن توجد معه قرينة مخصصة أو لا توجد
فإن لم توجد بقي مجملا لما ثبت من امتناع حمله على الكل
وإن وجدت القرينة فتلك القرينة إما أن تدل على حال كل واحد من مسميات اللفظ الغاءا أو اعتبارا أو على حال البعض الغاءا أو اعتبارا وإما على حال الكل م حيث هو كل الغاءا أو اعتبارا فهو مندرج تحت حال البعض لأن اللفظ إذا كان مفيدا لكل واحد من تلك الأفراد وللكل من حيث هو كل كان الكل أحد الأمور المسماة به فتكون القرينة الدالة عليه الغاءا أو اعتبارا دالة على حال بعض ما اندرج تحت تلك اللفظة
ف أما القسم الأول وهو ما يفيد اعتبار كل واحد من تلك المعاني فتلك المعاني إما أن تكون متنافية أو لا تكون
فان كانت متنافية بقي اللفظ مترددا بينها كما كان إلى أن يظهر المرجح
وإن لم تكن متنافية ف قال بعضهم الأدلة المقتضية لحمل اللفظة على كل معانيها معارضة للدليل المانع من حمل اللفظ المشترك على كل معانيه فتعتبر بينهما الترجيحات
وهذا خطأ لأن الدلالة المانعة من حمل اللفظ المشترك على كل معانيه دلالة قاطعة فلا تقبل المعارضة
سلمنا قبوله للمعارضة لكن لا معارضة ها هنا فان الدليلين اذا اقتضيا حمل اللفظ على كلا مدلوليه أمكن أن
يكون اللفظ كما كان موضوعا لكل واحد منهما بالاشتراك فهو أيضا موضوع للجميع أو أن المتكلم قد تكلم به مرتين و مع هذين الاحتمالين زال التعارض وإذا بطل التعارض ثبت أنه متى قامت الدلالة على كون كل واحد منهما مرادا وجب حمله عليهما
القسم الثاني
وهو الذي يكون مفيدا الغاء كل واحد من تلك المعاني وحينئذ يجب حمل اللفظ على مجازات تلك الحقائق الملغاة
ثم لا يخلو إما أن تكون تلك الحقائق الملغاة بحال لو لم تقم الدلالة على إلغائها كان البعض أرجح من البعض أو ليس الأمر كذلك
فان كان الأول فمجازاتها إما أن تكون متساوية في القرب أو لا تكون متساوية
فان تساوت المجازات في القرب وكانت إحدى الحقيقتين راجحة كان مجاز الحقيقة الراجحة راجحا
وان تفاوتت المجازات نظر فان كان مجازا الحقيقة الراجحة راجحا فلا كلام في رجحانه
وان كان مجاز الحقيقة المرجوحة راجحا وقع التعارض بين المجازين لأن هذا المجاز وإن كان راجحا إلا أن حقيقته مرجوحة
وذلك المجاز وإن كان مرجوحا إلا أن حقيقته راجحة
فقد اختص كل واحد منهما بوجه رجحان فيصار إلى الترجيح
وأما إن كانت الحقائق متساوية فإما أن يكون أحد المجازين
أقرب إلى حقيقته من المجاز الآخر أو لا يكون
فان كان الأول وجب العمل بالأقرب
وإن كان الثاني بقيت اللفظة مترددة بين مجازات تلك الحقائق لما ثبت من امتناع حمل اللفظ على مجموع معانيه سواء كانت حقيقية أو مجازية
القسم الثالث
وهو الذي يدل على الغاء البعض
فاللفظة المشتركة إما أن تكون مشتركة بين معنيين فقط أو أكثر
فإن كان الأول فقد زال الإجمال لأن اللفظ لما وجب حمله على معنى ولا معنى له إلا هذان وقد تعذر حمله على ذلك فيتعين حمله على هذا
وان كان الثاني وهو أن تكون المعاني أكثر من واحد
فعند قيام الدليل على إلغاء واحد منها بقي اللفظ مجملا في الباقي
وأما القسم الرابع
وهو الذي يدل على اعتبار البعض فهذا يزيل الإجمال سواء كانت اللفظة مشتركة بين معنيين أو أكثر
المسألة السابعة
في أنه يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه و سلم
والدليل على جوازه وقوعه وهو في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وفي قوله تعالى والليل إذا عسعس فانه مشترك
بين الاقبال والادبار
واحتج المانع بأن ذلك اللفظ إما أن يكون المراد منه حصول الفهم أو لا يكون
والثاني عبث
والأول لا يخلو إما أن يكون المراد منه حصول الفهم بدون بيان المقصود أو مع بيانه
والأول تكليف ما لا يطاق
والثاني لا يخلو إما أن يكون البيان مذكورا معه أو لا يكون
فان كان الأول كان تطويلا من غير فائدة وهو سفه وعبث
وإن كان الثاني أمكن أن لا يصل البيان إلى المكلف فحينئذ يبقى الخطاب مجهولا
والجواب
أن هذا غير وارد على مذهبنا في أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم 2 ما يريد
وأما الجواب على أصول المعتزلة فسيأتي في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب ان شاء الله تعالى
الباب السادس
في الحقيقة والمجاز
وهو مرتب على مقدمة وثلاثة أقسامأما المقدمة ففيها ثلاثة مسائل
المسألة الأولى في تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز في أصل اللغة أما الحقيقة فهي فعلية من الحق
ويجب البحث ها هنا عن أمرين
أحدهما أن الحق في اللغة هو الثابت لأنه يذكر في مقابلته الباطل فإذا كان الباطل هو المعدوم وجب أن يكون الحق هو الثابت
وثانيهما البحث عن وزن الفعيلة وفيه أيضا بحثان
الأول أن الفعيل قد يكون بمعنى المفعول وقد يكون بمعنى الفاعل فعلى التقدير الأول معنى الحقيقة المثبتة وعلى التقدير الثاني الثابتة
الثاني أن الياء في الفعلية لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة فلا يقال شاة أكيلة ونطيحة
وأما المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي في قولهم جزت موضع كذا أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع وهو في التحقيق راجع إلى الأول لأن الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا كان مترددا بين الوجود والعدم فكأنه ينتقل من الوجود إلى العدم أو من العدم إلى الوجود فاللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي شبيه بالمنتقل عن موضوعه
فلا جرم سمي مجازا
المسألة الثانية
في حد الحقيقة والمجاز
أحسن ما قيل في ما ذكره أبو الحسين وهو أن الحقيقة ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به وقد دخل فيه الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية
والمجاز ما أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول
وهذا القيد الأخير لم يذكره أبو الحسين و لا يد منه فإنه لولا العلاقة لما كان مجازا بل كان وضعا جديدا
وقوله معنى مصطلح عليه إنما يصح على قول من يقول
المجاز لا بد فيه من الوضع فأما من لم يقل به فيجب عليه حذفه
وأما قوله غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة ففيه سؤال وذلك أنه يقتضي خروج الاستعارة عن حد المجاز
بيانه أنا إذا قلنا على وجه الاستعارة رأيت أسدا فالتعظيم الحاصل من هذه الاستعارة ليس لأنا سميناه باسم الأسد ألا ترى أنا لو جعلنا الأسد علما له لم يحصل التعظيم ألبتة بل التعظيم إنما حصل لأنا قدرنا في ذلك الشخص صيرورته في نفسه أسدا لبلوغه في الشجاعة التي هي خاصية الأسد إلى الغاية القصوى فلما قدرنا أنه صار أسدا في نفسه أطلقنا عليه اسم الأسد وعلى هذا التقدير لا يكون اسم الأسد مستعملا في غير موضوعه الأصلي
وجوابه أنه يكفي في تحصيل التعظيم أن يقدر أنه حصل
له من القوة مثل ما للأسد فيكون استعمال لفظ الأسد فيه استعمالا للفظ في غير موضوعه الأصلي
وأعلم أن الناس ذكروا في تعريف الحقيقة والمجاز وجوها فاسدة
أحدها ما ذكره أبو عبد الله البصري ألا وهو أن الحقيقة ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل
والمجاز هو الذي لا ينتظم لفظه معناه إما لزيادة أو لنقصان أو لنقل
فالذي يكون للزيادة هو الذي ينتظم عند اسقاط الزيادة
كقوله تعالى ليس كمثله شيء فإنا لو أسقطنا الكاف استقام المعنى
والذي يكون للنقصان هو الذي ينتظم الكلام عند الزيادة كقوله تعالى واسئل القرية ولو قيل واسئل أهل القرية صح الكلام
والذي يكون لأجل النقل قوله رأيت أسدا وهو يعني الرجل الشجاع
وأعلم ان هذا التعريف خطأ لأن المجاز بالزيادة والنقصان إنما كان مجازا لأنه نقل عن موضوعه الأصلي إلى موضوع آخر في المعنى وفي الاعراب وإذا كان كذلك لم يجز جعلهما قسمين في مقابلة النقل
أما في المعنى فلأن قوله تعالى ليس كمثله شيء يفيد نفي مثل مثله وهو باطل لأنه يقتضي نفيه تعالى تعالى الله عن ذلك إلا أنه نقل عن هذا المعنى إلى نفي المثل وكذلك قوله تعالى واسئل القرية موضوع لسؤال القرية وقد نقل إلى أهلها
وأما في الاعراب فلأن الزيادة والنقصان متى لم يغير اعراب الباقي لم يكن ذلك مجازا فإنك إذا قلت جاءني زيد وعمرو فهو في الأصل جاءني زيد وجاءني عمرو إلا أنه حذف أحد اللفظين لدلالة الثاني عليه لكن لما لم يكن الحذف سببا لتغيير الإعراب لم يحكم عليه بكونه مجازا
وهكذا الكلام في جانب الزيادة
وأما إذا أوجبا تغيير الاعراب كانا مجازين وذلك إنما يتحقق عند نقل اللغة اللفظة من اعراب إلى اعراب آخر
وثانيها أيضا ما ذكره أبو عبد الله البصري ثانيا فقال الحقيقة ما أفيد بها ما وضعت له والمجاز ما أفيد به غير ما وضع له وهذا أيضا باطل
أما قوله في الحقيقة إنها ما أفيد بها ما وضعت له فباطل لأنه يدخل في الحقيقة ما ليس منها لأن لفظة الدابة إذا استعملت في الدودة والنملة فقد أفيد بها ما وضعت له في أصل اللغة مع أنه بالنسبة إلى الوضع العرفي مجاز فقد دخل المجاز العرفي فيما جعله حدا لمطلق الحقيقة وهو باطل
وقوله في المجاز إنه الذي أفيد به غير ما وضع له
فهو باطل بالحقيقة العرفية والشرعية فإن اللفظة أفيد بها والحالة هذه غير ما وضعت له في أصل اللغة فقد دخلت هذه الحقيقة في المجاز
وأيضا فقوله ما أفيد به غير ما وضع له إما أن يكون المراد منه أنه أفيد به غير ما وضع له بدون القرينة أو مع القرينة
والأول باطل لأن المجاز لا يفيد ألبتة بدون القرينة و الثاني ينتقض بما إذا استعمل لفظ السماء في الأرض فان اللفظ قد أفيد به غير ما وضع له مع أنه ليس ب مجاز فيه وأيضا ينتقض بالأعلام المنقولة
فإن قلت العلم لا يفيد
قلت حق إن العلم لا يفيد في المسمى صفة وليس بحق إنه لا يفيد أصلا بل هو يفيد عين تلك الذات لكنه لا يفيد صفة في الذات
وثالثها ما ذكره ابن جني وهو أن الحقيقة ما أقر
في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة
والمجاز ما كان بضد ذلك
وهذا ضعيف لأن ما ذكره في حد الحقيقة تخرج عنه الحقيقة الشرعية والعرفية وهما يدخلان فيما جعله حد المجاز
وأيضا فقوله و المجاز ما كان بضد ذلك معناه أن المجاز هو الذي ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة وهو باطل وإلا لكان استعمال لفظ الأرض في السماء مجازا
ورابعها ما ذكره عبد القاهر النحوي رحمه الله فقال
الحقيقة كل كلمة أريد بها عين ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه إلى غيره كالأسد للبهيمة المخصوصة
والمجاز كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الأول والثاني
وهذا التعريف أيضا ليس بجيد لأنه يقتضي خروج الحقيقة الشرعية والعرفية عن حد الحقيقة ودخولهما في حد المجاز وهو غير جائز
المسألة الثالثة
في أن لفظتي الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى المفهومين المذكورين حقيقة أو مجاز
الحق أن هاتين اللفظتين في هذين المفهومين مجازان بحسب أصل اللغة حقيقتان بحسب العرف
بيان الأول أما في الحقيقة فلأنا بينا أنها مأخوذة من الحق وبينا أن الحق حقيقة في الثابت ثم إنه نقل إلى العقد المطابق لأنه أولى بالوجود من العقد غير المطابق ثم نقل إلى القول المطابق لعين هذه العلة ثم نقل إلى استعمال اللفظ في موضوعه الأصلي لأن استعماله فيه تحقيق لذلك الوضع فظهر أنه مجاز واقع في الرتبة الثالثة بحسب اللغة الأصلية
و أما المجاز فإطلاقه على المعنى المذكور على سبيل المجاز أيضا لوجهين
الأول هو أن حقيقته العبور والتعدي وذلك
إنما يحصل في انتقال الجسم من حيز إلى حيز فأما في الألفاظ فلا فثبت أن ذلك إنما يكون على سبيل التشبيه
الثاني هو أن المجاز مفعل وبناء المفعل حقيقة إما في المصدر أو في الموضع فأما الفاعل فليس حقيقة فيه فاطلاقه على اللفظ المنتقل لا يكون إلا مجازا
هذا إذا قلنا إن المجاز مأخوذ من التعدي
و أما إذا قلنا إنه مأخوذ من الجواز كان حقيقة لا مجازا لأن الجواز كما يمكن حصوله في الأجسام يمكن حصوله في الأعراض
فاللفظ يكون موضوعا لذلك الجواز لأنه موضوع لجواز أن يستعمل في غير معناه الأصلي فيكون حقيقة من هذين
الوجهين إلا أنا قد ذكرنا أن الجواز إنما سمي جوازا مجازا عن معنى العبور والتعدي والله أعلم بالصواب
القسم الأول
في أحكام الحقيقةوفيه مسائل
المسألة الأولى
في اثبات الحقيقة اللغوية
والدليل عليه أن ها هنا ألفاظا وضعت لمعان ولا شك أنها قد استعملت بعد وضعها فيها ولا معنى للحقيقة إلا ذلك
واحتج الجمهور عليه بأن اللفظ إن استعمل في موضوعه الأصلي فهو الحقيقة وان استعمل في غير موضوعه الأصلي كان مجازا لكن المجاز فرع الحقيقة ومتى وجد
الفرع وجد الأصل فالحقيقة موجودة لا محالة
وهذا ضعيف لأن المجاز لا يستدعي إلا مجرد كونه موضوعا قبل ذلك لمعنى آخر
وستعرف أن اللفظ في الوضع الأول لا يكون حقيقة ولا مجازا فالمجاز غير متوقف على الحقيقة
المسألة الثانية
في الحقيقة العرفية
اللفظة العرفية هي التي انتقلت عن مسماها إلى غيره بعرف الاستعمال
ثم ذلك العرف قد يكون عاما وقد يكون خاصا
ولا شك في إمكان القسمين إنما النزاع في الوقوع فنقول
أما القسم الأول
فالحق أن تصرفات أهل العرف منحصرة في أمرين
أحدهما أن يشتهر المجاز بحيث يستنكر معه استعمال
الحقيقة ثم للمجاز جهات كما سيأتي تفصيلها ان شاء الله تعالى
منها حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كاضافتهم الحرمة إلى الخمر وهي في الحقيقة مضافة إلى الشرب
ومنها تسميتهم الشيء باسم شبيهه كتسميتهم حكاية كلام زيد بأنه كلام زيد
ومنها تسميتهم الشيء باسم ما له به تعلق كتسميتهم قضاء الحاجة بالغائط الذي هو المكان المطمئن من الأرض وكتسميتهم المزادة بالرواية التي هي اسم الجمل الذي يحملها
وثانيهما تخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة فإنها مشتقة من الدبيب ثم إنها اختصت ببعض البهائم و
الملك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة ثم اختص ببعض الرسل والجن مأخوذ من الاجنان ثم اختص ببعض من يستتر عن العيون وكذا القارورة والخابية موضوعتان لما يستقر فيه الشيء وتخبأ فيه ثم خصصا بشيء معين
فالتصرف الواقع على هذين الوجهين هو الذي ثبت من أهل العرف
ف أما على غير هذين الوجهين فلم يثبت عنهم فلا يجوز إثباته
والذي يدل على وجود هذا القدر من التصرف أن علامات الحقيقة كما سنذكرها حاصلة في هذه الألفاظ عرفا فوجب
كونها حقيقة فيه
و أما القسم الثاني
وهو العرف الخاص فهو ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم كالنقض والكسر والقلب والجمع والفرق للفقهاء
والجوهر والعرض والكون للمتكلمين
والرفع و النصب والجر للنحاة ولا شك في وقوعه
المسألة الثالثة
في الحقيقة الشرعية
وهي اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى سواء كان المعنى واللفظ مجهولين عند أهل اللغة أو كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما
واتفقوا على إمكانه واختلفوا في وقوعه
فالقاضي أبو بكر منع منه مطلقا
والمعتزلة أثبتوه مطلقا وزعموا أنها منقسمة إلى أسماء أجريت على الأفعال وهي الصلاة والزكاة والصوم وغيرها
وإلى أسماء أجريت على الفاعلين كالمؤمن والفاسق والكافر
وهذا الضرب يسمى بالأسماء الدينية تفرقة بينهما
وبين ما أجريت على الأفعال وإن كان الكل على السواء في أنه عرف شرعي
والمختار إن اطلاق هذه الألفاظ على هذه المعاني على سبيل المجاز من الحقائق اللغوية
لنا
أن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغوية لما كان القرآن كله عربيا وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم
أما الملازمة فلأن هذه الألفاظ مذكورة في القرآن فلو لم تكن إفادتها لهذه المعاني عربية لزم أن لا يكون القرآن كله عربيا
وأما فساد اللازم فلقوله تعالى قرآنا عربيا وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه
فإن قيل هذا الدليل فاسد الوضع لأنه يقتضي أن تكون هذه الألفاظ مستعملة في عين ما كان العرب يستعملونها فيه وبالاتفاق ليس كذلك
فإن الصلاة لا يراد بها في الشرع نفس الدعاء أو المتابعة فقط فإذن ما يقتضيه هذا الدليل لا تقولون به وما تقولون به لا يقتضيه هذا الدليل فكان فاسدا
سلمنا أن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني و إن لم تكن عربية لكنها في الجملة ألفاظ عربية فإنهم كانوا يتكلمون بها في الجملة وإن كانوا يعنون بها غير هذه المعاني واذا كان كذلك كانت هذه الألفاظ عربية
سلمنا أنها إذا استعملت في غير معانيها العربية لا تكون عربية لكن لم يلزم أن لا يكون القرآن عربيا
بيانه أن هذه الألفاظ قليلة جدا فلا يلزم خروج القرآن بسببها عن كونه عربيا فإن الثور الأسود لا يمتنع إطلاق اسم الأسود عليه لوجود شعرات بيض في جلده والشعر الفارسي يسمى فارسيا وان وجدت فيه كلمات كثيرة عربية
سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز خروج كل القرآن عن كونه عربيا
وأما الآيات فهي لا تدل على أن القرآن بكليته عربي لأن القرآن يقال بالاشتراك على مجموعه وعلى كل بعض منه لأربعة أوجه
أحدها لو حلف أن لا يقرأ القرآن فقرأ آية حنث في يمينه ولولا أن الآية مسماة بالقرآن وإلا لما حنث
الثاني أن الدليل يقتضي أن يسمى كل ما يقرأ قرآنا لأنه مأخوذ من القرأة أو القرء وهو الجمع خالفناه فيما عدا هذا الكتاب فنتمسك به في الكتاب بمجموعه وأجزائه
الثالث أنه يصح أن يقال هذا كل القرآن وهذا بعض القرآن ولو لم يكن القرآن إلا اسما للكل لكان الأول تكرار والثاني نقضا
الرابع قوله تعالى في سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا والمراد منه تلك السورة
فثبت أن بعض القرآن قرآن وإذا ثبت هذا لم يلزم من كون القرآن عربيا كونه بالكلية كذلك
سلمنا أن ما ذكرتم من الدليل يقتضي كون القرآن بالكلية عربيا لكنه معارض بما يدل على أنه ليس بالكلية عربيا فإن الحروف المذكورة في أوائل السور ليست عربية والمشكاة من لغة الحبشة والاستبرق و السجيل فارسيتان معربتان والقسطاس من لغة الروم
سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على مذهبكم لكنه معارض بأدلة أخرى من حيث الاجمال والتفصيل
أما الاجمال فهو أنه قد ثبت بالشرع معان لم تكن
ثابتة قبله وما لم يكن معقولا للعرب لا يجوز أن يضعوا له اسما وذا لم يكن لها شيء من الأسامي واحتيج إلى تعريفها فلا بد من وضع الأسامي لها كالولد الحادث والأداة الحادثة
أما التفصيل فهو أن يتبين في كل واحد من هذه الألفاظ أنها مستعلمة لا في معانيها الأصلية
أما الإيمان فهو في أصل اللغة عبارة عن التصديق
وفي الشرع عبارة عن فعل الواجبات ويدل عليه ثمانية أوجه
الأول أن فعل الواجبات هو الدين والدين هو الاسلام والاسلام هو الايمان ففعل الواجبات هو الايمان
و إنما قلنا إن فعل الواجبات هو الدين لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فقوله وذلك دين القيمة يرجع إلى كل ما تقدم فيجب أن يكون كل ما تقدم دينا وإنما قلنا إن الدين هو الإسلام لقوله تعالى إن الذين عند الله الإسلام
وإنما قلنا إن الاسلام هو الايمان لوجهين
أحدهما أن الايمان لو كان غير الاسلام لما كان مقبولا ممن ابتغاه لقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه
والثاني أنه تعالى استثنى المسلمين من المؤمنين في قوله تعالى فأخرجنا
من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولولا الاتحاد لما صح الاستثناء
الثاني قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم قيل صلاتكم
الثالث قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآية ثم إن الله تعالى أمر الرسول صلى الله عليه و سلم في آخر هذه الآية ان يستغفر لهم والفاسق لا يستغفر له الرسول حال كونه فاسقا بل يلعنه ويذمه فدل على أنه غير مؤمن
الرابع أن قاطع الطريق يخزى يوم القيامة والمؤمن لا يخزى يوم القيامة فقاطع الطريق ليس بمؤمن
أما الأول فلأن الله تعالى يدخله النار يوم القيامة وكل من كان كذلك فقد أخزي أما الأول فلقوله تعالى في صفتهم ولهم في الآخرة
عذاب عظيم
وأما الثاني فلقوله تعالى حكاية عنهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ولم يكذبهم فدل على صدقهم فيه
وإنما قلنا إن المؤمن لا يخزى يوم القيامة لقوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه
الخامس لو كان الايمان في عرف الشرع عبارة عن التصديق لما صح وصف المكلف به إلا في الوقت الذي يكون مشتغلا به على ما مر بيانه في باب الاشتقاق لكن ليس كذلك لأن من أتى بأفعال الايمان ولم يحبطها يقال إنه
مؤمن بل حال كونه نائما يوصف بأنه مؤمن
السادس يلزم أن يوصف بالايمان كل مصدق بأمر من الأمور سواء كان مصدقا بالله تعالى أو بالجبت والطاغوت
السابع من علم بالله تعالى ثم سجد للشمس وجب أن يكون مؤمنا وبالاجماع ليس كذلك
الثامن قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أثبت الايمان مع الشرك والتصديق بوحدانية الله لا يجامع الشرك فالايمان غير التصديق
أما الصلاة فهي في أصل اللغة إما للمتابعة كما يسمى الطائر الذي يتبع السابق مصليا
وإما للدعاء كما في قول الشاعر
... وصلى على دنها وارتسم
أو لعظم الورك كما قال بعضهم الصلاة إنما سميت صلاة لأن العادة في الصلاة أن يقف المسلمون صفوفا فإذا ركعوا كان رأس أحدهم عند صلا الآخر وهو عظم الورك
ثم إنها في الشرع لا تفيد شيئا من هذه المعاني الثلاثة لوجهين
الأول أنا إذا أطلقناها لم يخطر ببال السامع شيء من هذه الثلاثة ومن شأن الحقيقة المبادرة إلى الفهم
الثاني أن صلاة الامام والمنفردة صلاة ولم يوجد فيها شيء من المتابعة ولا يكون رأسه عند عظم ورك غيره
واذا انتقل الانسان من الدعاء إلى غيره لا يقال إنه فارق صلاته
ولأن صلاة الأخرس صلاة ولا دعاء فيها فدل على أن هذه اللفظة غير مستعملة في معانيها اللغوية
وأما الزكاة فإنها في اللغة للنماء والزيادة وفي الشرع لتنقيص المال على وجه مخصوص
وأما الصوم فإنه في اللغة لمطلق الامساك
وفي الشرع للامساك المخصوص ولا يتبادر الذهن عند سماعه إلى مطلق الامساك
و الجواب
قوله الدليل فاسد الوضع لأنه يقتضي كون هذه الألفاظ موضوعة في المعاني التي كانت العرب يستعملونها فيها
قلنا هذا الدليل يقتضي كون هذه الألفاظ مستعملة في المعاني التي كانت العرب يستعملونها فيها على سبيل الحقيقة فقط أو سواء كانت حقيقة أو مجازا
الأول ممنوع والثاني مسلم
بيانه أن العرب كما كانوا يتكلمون بالحقيقة كانوا يتكلمون بالمجاز
ومن المجازات المشهورة تسميتهم الشيء باسم جزئه كما يقال للزنجي إنه أسود والدعاء أحد أجزاء هذا المجموع المسمى بالصلاة بل هو الجزء المقصود لقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري و لأن المقصود من الصلاة التضرع والخضوع فلا جرم لم يكن اطلاق لفظ الصلاة عليه خارجا عن اللغة
فإن كان مذهب المعتزلة في هذه الأسماء الشرعية ذلك فقد ارتفع النزاع وإلا فهو مردود بالدليل المذكور
فإن قلت من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويزه وها هنا لم يوجد ذلك لأن هذه المعاني كانت معقولة لهم فكيف يمكن أن يقال إنهم جوزوا نقل لفظ الصلاة من الدعاء الذي هو أحد أجزاء هذا المجموع إليه
قلت لا نسلم أن شرط حسن استعمال المجاز تصريح أهل اللغة بجوازه
سلمنا ذلك إلا أنهم صرحوا بأن اطلاق اسم الجزء على الكل على سبيل المجاز جائز فدخلت هذه الصورة فيه
قوله افادة هذه اللفظة لهذا المعنى وإن لم تكن عربية
فلم لا يجوز أن يقال هذه اللفظة عربية
قلنا لأن كون اللفظة عربية ليس حكما حاصلا لذات اللفظة من حيث هي هي بل حيث هي دالة على المعنى المخصوص فلو لم تكن دلالتها على معناها عربية لم تكن اللفظة عربية
قوله اشتمال القرآن على ألفاظ قليلة لا يخرجه عن كونه عربيا
قلنا لا نسلم فإنه لما وجد فيه ما لا يكون عربيا وان كان في غاية القلة لم يكن المجموع عربيا وأما الثور الأسود الذي توجد فيه شعرة واحدة بيضاء والقصيدة الفارسية التي يوجد فيها ألفاظ عربية فلا نسلم جواز اطلاق الأسود والفارسي على مجموعهما على سبيل الحقيقة
والدليل عليه جواز الاستثناء ولولا أنه يمجموعه لا
يسمى بهذا الاسم حقيقة وإلا لما جاز الاستثناء
قوله القرآن اسم لمجموع الكتاب أوله ولبعضه قلنا بل للمجموع بدليل إجماع الأمة على أن الله تعالى ما أنزل إلا قرآنا واحدا ولو كان لفظ القرآن حقيقة في كل بعض منه لما كان القرآن واحدا
وما ذكروه من الوجوه الأربعة معارض بما يقال في كل آية وسورة إنه من القرآن وإنه بعض القرآن
قوله وجد في القرآن ألفاظ عربية
قلنا لا نسلم أما الحروف المذكورة في أوائل السور فعندنا أنها أسماء السور
وأما المشكاة والقسطاس والاستبرق فلا مانع من كونها عربية وإن كانت موجودة في سائر اللغات فإن توافق اللغات غير ممتنع
سلمنا أنها ليست بعربية لكن العام إذا خص يبقى حجة فيما وراءه
قوله هذه المسميات حدثت فلا بد م حدوث اسمائها
قلنا لم لا يكفي فيها المجاز وهو تخصيص هذه الألفاظ المطلقة ببعض مواردها فإن الإيمان و الصلاة و الصوم كانت موضوعة لمطلق التصديق والدعاء والامساك ثم تخصصت بسبب الشرع بتصديق معين ودعاء معين وامساك معين والتخصيص لا يتم إلا بادخال قيود زائدة على الأصل
وحينئذ يكون اطلاق اسم المطلق على المقيد اطلاقا لاسم الجزء على الكل
وأما الزكاة فإنها من المجاز الذي ينقل فيه اسم المسبب إلى السبب
والجواب عن المعارضة الأولى أنا لا نسلم أن فعل الواجبات هو الدين
أما قوله تعالى وذلك دين القيمة فنقول لا يمكن رجوعه إلى ما تقدم لوجهين
أحدهما أن ذلك لفظ الوجدان فلا يجوز صرفه إلى الأمور الكثيرة
والثاني أنه من ألفاظ الذكران فلا يجوز صرفه إلى إقامة الصلاة واذا كان كذلك فلا بد من إضمار شيء آخر وهو أن يقولوا ذلك الذي أمرتم به دين القيمة
وإذا كان كذلك فليسوا بأن يضمروا ذلك أولى منا بأن نضمر شيئا آخر وهو أن نقول معناه أن ذلك الاخلاص أو ذلك التدين دين القيمة ويكون قوله تعالى مخلصين له الدين دالا على الاخلاص
واذا تعارض الاحتمالات فعليهم الترجيح وهو معنا لأن إضمارهم يؤدي إلى تغيير اللغة واضمارنا يؤدي إلى عدم التغيير
والجواب عن الثاني أنا لا نسلم أن المراد في قوله تعالى وما كان
الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل المراد منه موضوعه اللغوي وهو التصديق بوجوب تلك الصلاة
وعن الثالث لا نسلم أن كلمة إنما للحصر
سلمناه لكنه معارض بآيات منها ما يدل على أن محل الايمان هو القلب وذلك يدل على مغايرة الايمان لعمل الجوارح قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان يشرح صدره للإسلام
وكان النبي صلى الله عليه و سلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
ومنها الآيات الدالة على أن الأعمال الصالحة أمور مضافة إلى الإيمان قال الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن
ومنها الآيات الدالة على مجامعة الايمان مع المعاصي قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وإن طائفتان من المؤمنين
اقتتلوا
وهذا هو الجواب عن سائر الآيات التي تمسكوا بها
والجواب عن الخامس أن ما ذكروه لازم عليهم لأنه قد يسمى مؤمنا حال كونه غير مباشر لأعمال الجوارح
والجواب عن السادس أنا نعترف بأن الايمان في عرف الشرع ليس ل مطلق التصديق بل التصديق الخاص وهو تصديق محمد صلى الله عليه و سلم في كل أمر ديني علم بالضرورة مجيئه به
وهو الجواب عن السابع والثامن
وأما الذي احتجوا به من أن الصلاة والصوم غير مستعملين في موضوعيهما اللغويين فمسلم ولكنهما مستعملان في أمور هي مجازات بالنسبة إلى تلك الموضوعات الأصلية وهم ما أقاموا الدلالة على فساده والله أعلم
فروع على القول بالنقل
الأول النقل خلاف الأصل ويدل عليه أمورأحدها أن النقل لا يتم إلا بثبوت الوضع اللغوي ثم نسخه ثم ثبوت الوضع الآخر
وأما الوضع اللغوي فإنه يتم بوضع واحد وما يتوقف على ثلاثة أشياء مرجوح بالنسبة إلى ما لا يتوقف إلى على شيء واحد
وثانيها أن ثبوت الحكم في الحال يفيد ظن البقاء على ما
سنقيم الدليل عليه في باب الاستصحاب وذلك يدل على أن البقاء على الوضع الأول أرجح
وثالثها أنه لو كان احتمال بقاء اللغة على الوضع الأصلي معارضا لاحتمال التغيير لما فهمنا عند التخاطب شيئا إلا إذا سألنا في كل لفظة هل بقيت على وضعها الأول
واذا لم يكن كذلك ثبت ما قلناه
الفرع الثاني لا شك في ثبوت الألفاظ المتواطئة في الاسماء الشرعية واختلفوا في وقوع الأسماء المشتركة
والحق وقوعها لأن لفظ الصلاة مستعمل في معان شرعية لا يجمعها جامع لأن اسم الصلاة يتناول ما لا قراءة فيه كصلاة
الأخرس وما لا سجود فيه ولا ركوع كصلاة الجنازة وما لا قيام فيه كصلاة القاعد والصلاة بالايماء على مذهب الشافعي رضي الله عنه ليس فيها شيء من ذلك وليس بين هذه الأشياء قدر مشترك يجعل مسمى الصلاة فيها حقيقة
وأما المترادف فالأظهر أنه لم يوجد لأنه ثبت أنه على خلاف الأصل فيقدر بقدر الحاجة
الفرع الثالث كما وجد الاسم الشرعي فهل وجد الفعل الشرعي والحرف الشرعي
الأقرب أنه لم يوجد أما أولا فبالإستقراء
وأما ثانيا فلأن الفعل صيغة دالة على وقوع المصدر بشيء غير معين في زمان معين فإن كان المصدر لغويا استحال كون
الفعل شرعيا
وإن كان شرعيا وجب كون الفعل أيضا شرعيا تبعا لكون المصدر شرعيا
فيكون كون الفعل شرعيا أمرا حصل بالعرض لا بالذات
الفرع الرابع في أن صيغ العقود انشاءآت ام إخبارات
لا شك أن قوله نذرت وبعت واشتريت صيغ الأخبار في اللغة وقد تستعمل في الشرع أيضا للإخبار و إنما النزاع في أنها حيث تستعمل لاستحداث الأحكام إخبارات أم إنشاءآت
والثاني هو الأقرب لوجوه
الأول أن قوله أنت طالق لو كان إخبارا لكان إما
أن يكون إخبارا عن الماضي أو الحال أو المستقبل والكل باطل فبطل القول بكونها أخبارا
أما أنه لا يمكن أن يكون إخبارا عن الماضي والحاضر فلأنه لو كان كذلك لامتنع تعليقه على الشرط لأن التعليق عبارة عن توقيف دخوله في الوجود على دخوله في غيره الوجود وما دخل في الوجود لا يمكن توقيف دخوله في الوجود على دخول غيره في الوجود ولما صح تعليقه على الشرط بطل كونه إخبارا عن الماضي أو الحال
وأما أنه لا يمكن أن يكون إخبارا عن المستقبل فلأن قوله أنت طالق في دلالته على الإخبار عن صيرورتها موصوفة بالطلاق في المستقبل ليس أقوى من تصريحه بذلك وهو قوله ستصيرين طالقا في المستقبل لكنه لو صرح بذلك فإنه لا يقع الطلاق فما هو أضعف منه وهو قوله أنت طالق
أولى بأن لا يقتضي وقوع الطلاق
الثاني أن هذه الصيغ لو كانت أخبارا لكانت إما أن تكون كذبا أو صدقا
فان كانت كذبا فلا عبرة بها وان كانت صدقا فوقوع الطالقية إما أن يكون متوقفا على حصول هذه الصيغ أو لا يكون
فإن كان متوقفا عليه فهو محال لأن كون الخبر صدقا يتوقف على وجود المخبر عنه والمخبر عنه ها هنا هو وجود الطالقية فلإخبار عن الطالقية يتوقف كونها صدقا على حصول الطالقية فلو توقف حصول الطالقية على هذا الخبر لزم الدور وهو محال
وإن لم يكن متوقفا عليه فهذا الحكم لا بد له من سبب آخر فبتقدير حصول ذلك السبب تقع الطالقية وإن لم يوجد هذا
الخبر
وبتقدير عدمه لا توجد وإن وجد هذا الإخبار وذلك باطل بالاجماع
فان قيل لم لا يجوز أن يكون تأثير ذلك المؤثر في حصول الطالقية يتوقف على هذه اللفظة
قلت هذه اللفظة إذا كانت شرطا لتأثير المؤثر في الطالقية وجب تقدمها على الطالقية لكنا بينا أنا متى جعلناه خبرا صادقا لزم تقدم الطالقية عليها فيعود الدور
الثالث قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أمر بالتطليق فيجب أن يكون قادرا على التطليق ومقدوره ليس إلا قوله طلقت فدل على أن ذلك مؤثر في الطالقية
الرابع لو أضاف الطلاق إلى الرجعية وقع وان كان صادقا بدون الوقوع فثبت أنه انشاء لا إخبار والله أعلم
القسم الثاني
في المجازوفيه مسائل
المسألة الأولى
في أقسام المجاز
المجاز إما أن يقع في مفردات الألفاظ فقط أو في مركباتها أو فيهما معا
أما الذي يقع في المفردات فكإطلاق لفظ الأسد على الشجاع والحمار على البليد
وأما الذي يقع في التركيب فهو أن يستعمل كل واحد من الألفاظ المفردة في موضوعه الأصلي لكن التركيب لا
يكون مطابقا لما في الوجود كقوله
... أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كر الغداة ومر العشي ...
فكل واحد من الألفاظ المفردة التي في هذا البيت مستعمل في موضوعه الأصلي
لكن اسناد أشاب إلى كر الغداة غير مطابق لما عليه الحقيقة فإن الشيب يحصل بفعل الله تعالى لا بكر الغداةوأما الذي يقع في المفردات والتركيب معا فكقولك لمن تداعبه أحياني اكتحالي بطلعتك فإنه استعمل الإحياء لا في موضوعه الأصلي ولفظ الاكتحال لا في موضوعه الأصلي ثم نسب الإحياء إلى الاكتحال مع أنه غير منتسب إليه
وقد جاء في القرآن والأخبار من الأقسام الثلاثة شيء كثير والأصوليون لم يتنبهوا للفرق بين هذه الأقسام وإنما لخصه الشيخ عبد القاهر النحوي
المسألة الثانية
في إثبات المجاز المفرد
الدليل عليه أنهم يستعملون الأسد في الشجاع والحمار في البليد مع اعترافهم بأن الأسد والحمار غير موضوعين في أول الأمر لهذين المعنيين بل إنهما أطلقا عليهما لما بين مفهوميهما وبين هذين الأمرين من المشابهة ولا معنى للمجاز إلا ذلك
واحتج المانعون منه بأن اللفظ لو أفاد المعنى على سبيل المجاز فإما أن يفيده مع القرينة أو بدون القرينة
والأول باطل لأنه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة فيه لا مجازا وبدون تلك القرينة غير مفيد له أصلا فلا يكون حقيقة ولا مجازا
فظهر أن اللفظ على هذا التقدير لا يكون مجازا لا حال القرينة ولا حال عدم القرينة
والثاني أيضا باطل لأن اللفظ لو أفاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه لأنه لا معنى للحقيقة إلا ما يكون مستقلا بالإفادة بدون القرينة
والجواب أن هذا نزاع في العبارة ولنا أن نقول اللفظ الذي لا يفيد إلا مع القرينة هو المجاز ولا يقال اللفظ مع القرينة حقيقة فيه لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يجعل المجموع لفظا واحدا دالا على المسمى
المسألة الثالثة
في أقسام هذا المجاز والذي يحضرنا منه اثنا عشر وجها
أحدها اطلاق اسم السبب على المسبب والأسباب أربعة القابل والصورة والفاعل والغاية
مثال تسمية الشيء باسم قابله قولهم سال الوادي ومثال التسمية باسم الصورة تسميتهم اليد بالقدرة
ومثال التسمية باسم بالفاعل حقيقة أو ظنا تسمية المطر بالسماء
ومثال التسمية باسم الغاية تسمية العنب بالخمر والعقد بالنكاح وثانيها اطلاق اسم المسبب على السبب كتسمية المرض الشديد والمذلة العظيمة بالموت ويحتمل أن يكون وجه المجاز ها هنا ما بين الأمرين من المشابهة
ثم ها هنا بحثان
البحث الأول أن العلة الغائية حال كونها ذهنية علة العلل وحال كونها خارجية معلولة العلل فقد حصلت لها علاقتا العلية والمعلولية وكل واحدة منها علة لحسن التجوز إلا أن نقل اسم السبب إلى المسبب أحسن من العكس لأن السبب المعين يقتضي المسبب المعين لذاته
وأما المسبب المعين فإنه لا يقتضي لذاته السبب المعين على ما بينا الفرق بينهما في الكتب العقلية
وإذا كان كذلك كان اطلاق اسم السبب على المسبب أولى من العكس
الثاني هو أن العلة الغائية لما اجتمع فيها الوجهان السببية والمسببية كان استعمال اللفظ المجازي فيها أولى من سائر المواضع لاجتماع الوجهين
وثالثها تسمية الشيء باسم ما يشابهه كتسمية الشجاع أسدا و البليد حمارا وهذا القسم على الخصوص هو المسمى بالمستعار
ورابعها تسمية الشيء باسم ضده كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ويمكن جعل ذلك من باب المجاز للمشابهة
لأن جزاء السيئة يشبهها في كونها سيئة بالنسبة إلى من يصل إليه ذلك الجزاء
وخامسها تسمية الجزء باسم الكل كاطلاق اللفظ العام مع أن المراد منه الخصوص
وسادسها تسمية الكل باسم الجزء كما يقال للزنجي إنه أسود والأول أولى لأن الجزء لازم الكل أما الكل فليس بلازم للجزء
وسابعها تسمية إمكان الشيء باسم وجوده كنا يقال للخمر التي في الدن إنها مسكرة
وثامنها إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه كقولنا للانسان بعد فراغه من الضرب إنه ضارب
وتاسعها المجاورة كنقل اسم الراوية من الجمل إلى ما يحمل عليه من ظرف الماء وكتسمية الشراب بالكأس ويمكن جعله من المجاز بسبب القابل
وعاشرها المجاز بسبب أن أهل العرف تركوا استعماله فيما كانوا يستعملونه فيه ك الدابة اذا استعملت في الحمار
فإن قلت لفظ الدابة إما أن يكون مجازا من حيث إنه صار مستعملا في الفرس وحده أو من حيث منع من استعماله في غيره
والأول من باب اطلاق اسم العام على الخاص فلا يكون قسما آخر والثاني باطل لأن المجازية كيفية عارضة للفظة من جهة دلالتها على المعنى لا من جهة عدم دلالتها على الغير
قلت لفظ الدابة اذا استعمل في الحمار والكلب كان ذلك مجازا بالنسبة إلى الوضع العرفي لأنه يكون مستعملا في غير موضعه لعلاقة بينه وبين موضوعه ويكون ذلك حقيقة بالنسبة إلى الوضع اللغوي إلا أن هذا المجاز من باب المشابهة فلا يكون في الحقيقة قسما آخر
وحادي عشرها المجاز بسبب الزيادة والنقصان وقد ذكرنا مثاليهما وبينا كيفية الحال فيهما
وثاني عشرها تسمية المتعلق باسم المتعلق كتسمية المعلوم علما والمقدور قدرة
المسألة الرابعة
في أن المجاز بالذات لا يدخل دخولا أوليا إلا في أسماء الأجناس
أما الحرف فلا يدخل فيه المجاز بالذات لأن مفهومه غير مستقل بنفسه بل لا بد أن ينضم إليه شيء آخر لتحصل الفائدة
فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة فيه وإلا فهو مجاز في المركب لا في المفرد
وأما الفعل فهو لفظ دال على ثبوت شيء لموضوع غير معين في زمان معين فيكون الفعل مركبا من المصدر وغيره فما لم يدخل المجاز في المصدر استحال دخوله في الفعل الذي لا يفيد إلا ثبوت ذلك المصدر لشيء
وأما الاسم فهو إما علم أو مشتق أو اسم جنس
أما العلم فلا يكون مجازا لأن شرط المجاز أن يكون النقل لأجل علاقة بين الأصل والفرع وهي غير موجودة في الأعلام
و أما المشتق فما لم يتطرق المجاز إلى المشتق منه فلا يتطرق إلى المشتق الذي لا معنى له إلا أنه أمر ما حصل له المشتق منه
فاذن المجاز لا يتطرق في الحقيقة إلا إلى أسماء الأجناس والله أعلم
المسألة الخامسة
في أن استعمال اللفظ في معناه المجازي يتوقف على السمع
الدليل عليه أن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأجل المشابهة في الشجاعة لكن الرجل الشجاع كما يشبه الأسد في
شجاعته فقد يشبهه في صفات أخر كالبخر وغيره فلو كانت المشابهة كافية في ذلك ل جاز استعارة الأسد للأبخر ولما لم يجز ذلك صح قولنا
ولأنهم قد يطلقون النخلة على الرجل الطويل ولا يطلقونها على غير الانسان وذلك يدل على اعتبار الاستعمال في المجاز
و احتج المخالف بوجهين
الأول اتفقوا على أن وجوه المجازات والاستعارات مما يحتاج في استخراجها إلى تدقيق النظر وما يكون نقليا لا يكون كذلك
الثاني أنك إذا قلت رأيت أسدا وعنيت به الشجاع فالغرض من التعظيم إنما يحصل بإعارة معنى الأسد له فإنك لو أعطيته الاسم بدون المعنى لم يحصل التعظيم
وإذا كانت إعارة اللفظ تابعة لاعارة المعنى وإعارة المعنى حاصلة بمجرد قصد المبالغة وجب أن لا يتوقف استعمال اللفظ المستعار على السمع
والجواب عن الأول أن المستخرج بالفكر جهات حسن المجاز
وعن الثاني أن هذه الاعارة ليست أمرا حقيقيا بل أمرا تقديريا فلم لا يجوز أن يمنع الواضع منه في بعض المواضع دون البعض
المسألة السادسة
في أن المجاز مركب عقلي
ومثاله في القرآن قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها وقوله مما تنبت الأرض
فالإخراج والإنبات غير مستندين في نفس الأمر إلى الأرض بل إلى الله تعالى وذلك حكم عقلي ثابت في نفس الأمر فنقله عن متعلقه إلى غيره نقل لحم عقلي لا للفظ لغوي فلا يكون هذا المجاز إلا عقليا
فان قلت لم لا يجوز أن يقال صيغة أخرج و أنبت وضعت في أصل اللغة بازاء صدور الخروج والنبات من القادر فاذا استعملت في صدورهما من الأرض فقد استعملت الصيغة في غير موضوعها فيكون هذا المجاز لغويا
قلت إن أمثلة الأفعال لا تدل بالتضمن على خصوصية المؤثر
والدليل عليه وجوه
أحدها أنه لو كانت كذلك لكان المفهوم من لفظة أخرج أن القادر صدر عنه هذا الأثر فيكون مجرد قولنا
أخرج خبرا تاما فكان يلزم أن يتطرق إليه وحده التصديق ولتكذيب ومعلوم أنه ليس كذلك
وثانيها أنه يصح أن يقال أخرجه القادر ولو كان القادر جزءا من مفهوم أخرج لكان التصريح بذكر القادر تكرارا
2 - وثالثها هب أنها دالة على صدور الفعل عن القادر فأما عن القادر المعين فلا وإلا لزم حصول الاشتراك اللفظي بحسب كل واحد واحد من القادرين
إذا ثبت هذا فنقول إذا أضيف ذلك الفعل إلى غير ذلك القادر الذي هو صادر عنه لم يكن التغيير واقعا في مفهومات الألفاظ بل في إسناد مفهوماتها إلى غير ما هو مستندها
فإن قال قائل ما الفرق بين هذا المجاز وبين الكذب
قلنا الفارق هو القرينة وهي قد تكون حالية وقد تكون مقالية
أما الحالية فهي ما إذا علم أو ظن أن المتكلم لا يتكلم بالكذب فيعلم أن المراد ليس هو الحقيقة بل المجاز
ومنها أن يقترن الكلام بهيئات مخصوصة قائمة بالمتكلم دالة على أن المراد ليس هو الحقيقة بل المجاز
ومنها أن يعلم بسبب خصوص الواقعة أنه لم يكن للمتكلم داع إلى ذكر الحقيقة فيعلم أن المراد هو المجاز
وأما القرينة المقالية فهي أن يذكر المتكلم عقيب ذلك الكلام ما يدل على أن المراد من الكلام الأول غير ما أشعر به ظاهره
المسألة السابعة
في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه و سلم
الأكثرون جوزوا ذلك خلافا لأبي بكر بن داود الأصفهاني
لنا قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه وجاء ربك
وقد ثبت بالدليل أنه لا يجوز أن يكون المراد منها ظواهرها فوجب صرفها إلى غير ظواهرها وهو المجاز
و احتج المخالف بأمور
أحدها لو خاطب الله بالمجاز لجاز وصفه بأنه متجوز و مستعير
وثانيها أن المجاز لا ينبيء بنفسه عن معناه فورود القرآن به يقتضي الالتباس
وثالثها أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة وهو على الله تعالى محال
ورابعها أن كلام الله تعالى كله حق وكل حق فله حقيقة وكل ما كان حقيقة فإنه لا يكون مجازا
و الجواب عن الأول أن أسامي الله تعالى توقيفية
وبتقدير كونها اصطلاحية لكن لفظ المتجوز يوهم كونه تعالى فاعلا ما لا ينبغي فعله وهو في حق الله تعالى محال
وعن الثاني أنه لا التباس مع القرينة الدالة على المراد
وعن الثالث أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز لأغراض سنذكرها ان شاء الله تعالى
وعن الرابع أن كلام الله تعالى كله حقيقة بمعنى أنه صدق لا بمعنى كون ألفاظه بأسرها مستعملة في موضوعاتها الأصلية والله أعلم
المسألة الثامنة
في الداعي إلى التكلم بالمجاز
العدول عن الحقيقة إلى المجاز إما لأجل اللفظ أو المعنى أو لهما
أما الذي لأجل اللفظ فإما أن يكون لأجل جوهر اللفظ أو لأجل أحوال عارضة للفظ
أما الأول فهو أن يكون اللفظ الدال على الشيء بالحقيقة ثقيلا على اللسان أما لأجل مفردات حروفه أو لتنافر تركيبه أو لثقل وزنه واللفظ المجازي يكون عذبا فتترك الحقيقة إلى هذا المجاز
وأما الثاني وهو أن يكون لأجل أحوال عارضة للفظ فهو أن تكون اللفظة المجازية صالحة للشعر أو السجع وسائر اصناف البديع واللفظة الحقيقية لا تصلح لذلك
وأما الذي يكون لأجل المعنى فقد تترك الحقيقة إلى المجاز لأجل التعظيم والتحقير ولزيادة البيان ولتلطيف الكلام أما فكما يقال سلام على المجلس العالي
فإنه تركت الحقيقة ها هنا لأجل الاجلال
وأما التحقير فكما يعبر عن قضاء الحاجة بالغائط الذي هو اسم للمكان المطمئن من الأرض
وأما زيادة البيان فقد تكون لتقوية حال المذكور وقد تكون لتقوية الذكر
أما الأول فكقولهم رأيت أسدا فإنه لو قال رأيت انسانا يشبه الأسد في الشجاعة لم تكن في البلاغة كما اذا قال رأيت أسدا
وتحقيق هذا الفرق مذكور في كتابنا في الاعجاز
وأما الثاني فهو المجاز الذي يذكر للتأكيد
وأما تلطيف الكلام فهو أن النفس إذا وقفت على تمام كلام فلو وقفت على تمام المقصود لم يبق لها شوق إليه
أصلا لأن تحصيل الحاصل محال وإن لم تقف على شيء منه أصلا لم يحصل لها شوق إليه
فأما إذا عرفته من بعض الوجوه دون البعض فإن القدر المعلوم يشوقها إلى تحصيل العلم بما ليس بمعلوم فيحصل لها بسبب علمها بالقدر الذي علمته لذة وبسبب حرمانها من الباقي ألم فتحصل هناك لذات وآلام متعاقبة واللذة إذا حصلت عقيب الألم كانت أقوى وشعور النفس بها أتم
اذا عرفت هذا فنقول إذا عبر عن الشيء باللفظ الدال عليه على سبيل الحقيقة حصل كمال العلم به فلا تحصل اللذة القوية أما إذا عبر عنها بلوازمها الخارجية عرف لا على سبيل الكمال فتحصل الحالة المذكورة التي هي كالدغدغة النفسانية فلأجل هذا كان التعبير عن المعاني بالعبارات المجازية ألذ من التعبير عنها بالألفاظ الحقيقية والله أعلم
المسألة التاسعة
في أن المجاز غير غالب على اللغات
قال أبو الفتح ابن جني أكثر اللغة مجاز أما في الأفعال فنحو قولك قام زيد وقعد عمرو فإن الفعل يفيد المصدر فقولك قام زيد معناه كان منه القيام أي هذا الجنس من الفعل والجنس يتناول جميع الأفراد ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام لأنه لا يجتمع لانسان واحد في وقت واحد ولا في مائة ألف سنة القيام كله الداخل تحت الوهم
أقول هذا ركيك لأنه ظن أن المصدر لفظ دال على جميع أشخاص تلك الماهية وهو باطل بل المصدر لفظ دال على الماهية أعني القدر المشترك بين الواحد والكل والماهية من حيث هي
هي لا تستلزم الوحدة و لا الكثرة وإذا كان كذلك كان الفعل المشتق منه لا دلالة على الكثرة ولا على الوحدة
وقال أيضا قولك ضربت عمرا مجاز من جهة أخرى لأنك إنما ضربت بعضه لا جميعه ولهذا إذا احتاط الانسان قال ضربت رأسه وهذا أيضا يكون مجازا وذلك عندما إذا ضربت جانبا من جوانب رأسه فقط
اعترض أبو محمد بن متويه فقال المتألم بالضرب جملة عمرو لا عضو منه
أقول هذا الاعتراض ساقط لأن ابن جني إنما ألزم
المجاز في لفظ الضرب لا في لفظ التألم والضرب عبارة عن امساس جسم حيوان بعنف والامساس حكم يرجع إلى الاجزاء لا إلى الجملة بالاتفاق فكان المضروب بالحقيقة هو الجزء الممسوس فقط فظهر سقوط هذا الاعتراض
وأقول ها هنا وجوه أخر من المجازات السائغة فإني إذا قلت ضربت زيدا فزيد ليس عبارة عن جملة البنية المشاهدة لأنا نعلم أن زيدا هو الذي كان موجودا وقت ولادته ونعلم أن أجزاءه وقت شبابه أكثر مما كانت وقت ولادته ولا شك أن زيدا هو تلك الأجزاء الباقية من أول حدوثه إلى آخر فنائه وتلك الأجزاء قليلة فإذن المسمى بزيد هو تلك الأجزاء
فإذا قلت ضربت زيدا فلعل هذا الامساس ما وقع على تلك الأجزاء فيكون الكلام أيضا مجازا من هذا الوجه
ثم ها هنا دقيقة وهي أن هذه المجازات من باب المجاز العقلي لأنك إذا قلت رأيت زيدا و ضربت عمروا فصيغتا رأيت وضربت مستعملتان في موضوعيهما الأصليين فلا يكون مجازا وأما لفظة زيد فهي من الأعلام فلا تكون مجازا فلم يبق إلا أن المجاز واقع في النسبة فيكون مجازا عقليا والله أعلم
المسألة العاشرة
في أنت المجاز على خلاف الأصل
والذي يدل عليه وجوه
أحدها أن اللفظ إذا تجرد فإما أن يحمل على حقيقته أو على مجازه أو عليهما أو لا على واحد منهما والثلاثة الأخيرة باطلة فتعين الأول
و إنما قلنا إنه لا يجوز حمله على مجازه لأن شرط
الحمل على المجاز حصول القرينة فإن الواضع لو أمر بحمل اللفظ عند تجرده على ذلك المعنى لكان حقيقة فيه إذ لا معنى للحقيقة إلا ذلك
وأما أنه لا يجوز حمله عليهما معا فظاهر لأن الواضع لو قال احملوه وحده عليهما معا كان اللفظ حقيقة في ذلك المجموع ولو قال احملوه إما على هذا أو على ذاك كان مشتركا بينهما
وأما أنه لا يجوز أن لا يحمل على واحد منهما ألبتة فلأنه على هذا التقدير يكون اللفظ حال تجرده من المهملات لا من المستعملات
واذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة تعين القسم الأول وهو المطلوب
وثانيها أن المجاز لا يتحقق إلا عند نقل اللفظ من شيء إلى شيء لعلاقة بينهما وذلك يستدعي أمورا ثلاثة
وضعه للأصل ثم نقله إلى الفرع ثم علة للنقل
وأما الحقيقة فإنه يكفي فيها أمر واحد وهو وضعه للأصل
ومن المعلوم أن الذي يتوقف على شيء واحد أغلب وجودا مما يتوقف على ذلك الشيء مع شيئين آخرين معه
وثالثها أن واضع اللفظ للمعنى إنما يضعه له ليكتفي به في الدلالة عليه وليستعمل فيه فكأنه قال اذا سمعتموني أتكلم بهذا الكلام فاعلموا أنني أعني هذا المعنى وإذا تكلم به متكلم بلغتي فليعن به هذا
فكل من تكلم بلغته يجب أن يعنى به ذلك المعنى ولهذا يسبق إلى أذهان السامعين ذلك المعنى دون ما هو مجاز فيه
ولو قال لنا مثل ذلك في المجاز لكان حقيقة ولم يكن مجازا
ورابعها إجماع الكل على أن الأصل في الكلام الحقيقة
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما كنت أعرف معنى الفاطر حتى اختصم إلي شخصان في بئر فقال أحدهما فطرها أبي أي اخترعها
وقال الأصمعي ما كنت أعرف الدهاق حتى سمعت جارية بدوية تقول اسقني دهاقا أي ملآنا
فها هنا استدلوا بالاستعمال على الحقيقة فلولا أنهم عرفوا أن
الأصل في الكلام الحقيقة وإلا لما جاز لهم ذلك
وخامسها لو لم يكن الأصل في الكلام الحقيقة لكان الأصل إما أن يكون هو المجاز وهو باطل باجماع الأمة أو لا يكون واحد منهما أصلا فحينئذ يتردد كل كلام الشارع بين أمرين فيصير الكل مجملا وهو باطل بالاجماع
ويلزم أن يصير كل ما يتكلم به في العرف مجملا لتردد تلك الألفاظ بين حقائقها ومجازاتها ولو كان الكل مجملا لما فهمنا المراد في شيء من الألفاظ إلا بعد الاستفسار وطلب تعيين المراد ولما كان ذلك باطلا علمنا أن الأصل في الكلام الحقيقة
فرع
إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فأيهما أولى
فعند أبي حنيفة رضي الله عنه الحقيقة المرجوحة أولى
وعند أبي يوسف رحمه الله المجاز الراجح أولى
ومن الناس من قال يحصل التعارض لأن كل واحد منهما راجح على الآخر من وجه ومرجوح من وجه آخر فيحصل التعارض
القسم الثالث
في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجازوفيه مسائل
المسألة الأولى
في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا
أما في الأعلام فظاهر
وأما في غيرها فالوضع الأول ليس بحقيقة ولا مجاز لأن الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه فالحقيقة لا تكون حقيقة إلا إذا كانت مسبوقة بالوضع الأول
والمجاز هو المستعمل في غير موضوعه الأصلي فيكون هو أيضا مسبوقا بالوضع الأول
فثبت أن شرط كون اللفظ حقيقة أو مجازا حصول الوضع الأول فالوضع الأول وجب أن لا يكون حقيقة ولا مجازا
المسألة الثانية
في أن اللفظ الواحد هل يكون حقيقة ومجازا معا
أما بالنسبة إلى معنيين فلا شك في جوازه
وأما بالنسبة إلى معنى واحد فإما أن يكون بالنسبة إلى وضعين أو إلى وضع واحد
أما الأول فجائز لأن لفظ الدابة بالنسبة إلى الحمار حقيقة بحسب الوضع اللغوي مجاز بحسب الوضع العرفي
وأما الثاني فهو محال لامتناع اجتماع النفي والاثبات في جهة واحدة
المسألة الثالثة
في أن الحقيقة قد تصير مجازا وبالعكس
الحقيقة إذا قل استعمالها صارت مجازا عرفيا والمجاز إذا كثر استعماله صار حقيقة عرفية
المسألة الرابعة
في أن اللفظ متى كان مجازا فلا بد وأن يكون حقيقة في غيره ولا ينعكس
أما الأول فلأن المجاز هو المستعمل في غير موضوعه الأصلي وهذا تصريح بأنه وضع في الأصل لمعنى آخر فاللفظ متى استعمل في ذلك الموضوع كان حقيقة فيه
وأما الثاني فلأن المجاز هو المستعمل في غير موضوعه الأصلي لمناسبة بينهما وليس يلزم من كون اللفظ موضوعا لمعنى أن يصير موضوعا لشيء آخر بينه وبين الأول مناسبة
المسألة الخامسة
فيما به تنفصل الحقيقة عن المجاز
الفروق المذكورة منها صحيحة ومنها فاسدة
أما الصحيحة فنقول الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالتنصيص أو الاستدلال
أما التنصيص فمن ثلاثة أوجه
أحدها أن يقول الواضع هذا حقيقة وذلك مجاز
وثانيها أن يذكر أحدهما
وثالثها أن يذكر خواصهما
و أما الاستدلال فمن وجوه أربعة
أحدها أن يسبق المعنى إلى افهام جماعة أهل اللغة عند سماع اللفظ من دون قرينة فيعلم أنها حقيقة فيه فإن السامع لولا أنه اضطر من قصد الواضعين إلى أنهم وضعوا اللفظ لذلك المعنى لما سبق إلى فهمه ذلك المعنى دون غيره
وثانيها أن أهل اللغة إذا أرادوا إفهام غيرهم معنى اقتصروا على عبارات مخصوصة واذا عبروا عنه بعبارات أخرى لم يقتصروا عليها بل ذكروا معها قرينة فيعلم أن الأول حقيقة إذ لولا أنه استقر في قلوبهم استحقاق تلك اللفظة لذلك المعنى لما اقتصروا عليها
وثالثها إذا علقت الكلمة بما يستحيل تعليقها به علم أنها في أصل اللغة اللغة غير موضوعة له فيعلم أنها مجاز فيه كقوله تعالى واسئل القرية
ورابعها أن يضعوا اللفظ لمعنى ثم يتركوا استعماله إلا في بعض مجازاته ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشيء علمنا كونه مجازا عرفيا مثل استعمال لفظ الدابة في الحمار
فالخاصيتان الأوليان للحقيقة والأخريان للمجاز
و أما الفروق الضعيفة فقد ذكر مها الغزالي وجوها أربعة
أحدها أن الحقيقة جارية على الاطراد فقولنا عالم لما صدق على ذي علم واحد صدق على كل ذي علم والمجاز ليس كذلك فإنه لما صح واسئل
القرية صح واسأل البساط
وهذا ضعيف لأن الدعوى العامة لا تصح بالمثال الواحد
وأيضا إن أراد باطراد الحقيقة استعمالها في جميع موارد نص الواضع فالمجاز أيضا كذلك لأنه يجوز استعماله في جميع موارد نص الواضع فلا يبقى بينهما فيه فرق
وان أراد استعمال الاسم في غير موضع نص الواضع لكونه مشاركا للمنصوص عليه في المعنى فهذا هو القياس وعنده لا قياس في اللغات
سلمنا جواز القياس في اللغة لكن دعوى اطراد الحقيقة ممنوعة لأن الحقيقة لا تطرد في مواقع كثيرة
الأول أن يمنع منه العقل كلفظ الدليل عند من يقول إنه حقيقة في فاعل الدلالة فإنه لما كثر استعماله في نفس الدلالة لا جرم لم يحسن استعماله في حق الله تعالى إلا مقيدا
والثاني أن يمنع السمع منه كتسمية الله تعالى بالفاضل والسخي فإنها ممنوعة شرعا مع حصول الحقيقة فيه
الثالث ان تمنع منه اللغة كامتناع استعمال الأبلق في غير الفرس
فان اعتذروا عنه بأن الأبلق موضوع للمتلون بهذين اللونين بشرط كونه فرسا فنقول جوز في كل مجاز لا يطرد أن يكون سبب عدم اطراده ذلك
وحينئذ لا يمكن الاستدلال بعدم الاطراد على كونه مجازا
وثانيها قال الغزالي رحمه الله امتناع الاشتقاق دليل كون اللفظ مجاز فإن الأمر لما كان حقيقة في القول اشتق منه الآمر والمأمور ولما لم يكن حقيقة في الفعل لم يوجد منه الاشتقاق
وهذا ضعيف لما تقدم أن الدعوى العامة لا تصح بالمثال الواحد و لأنه ينتقض بقولهم للبليد حمار وللجمع حمر
وعكسه أن الرائحة حقيقة في معناها ولم يشتق منها الاسم
وثالثها أن تختلف صيغة الجمع على الاسم فيعلم أنه مجاز في أحدهما إذ الأمر الحقيقي يجمع على الأوامر وإذا أريد به الفعل يجمع على أمور
وهو ضعيف لأن اختلاف الجمع لا اشعار له ألبتة بكون اللفظ حقيقة في معناه أو مجازا
ورابعها أن المعنى الحقيقي إذا كان متعلقا بالغير فإذا استعمل فيما لا تعلق له بشيء كان مجازا فالقدرة إذا أريد بها الصفة كان متعلقا بالمقدور وإذا أطلق على البيان الحسن لم يكن له متعلق فيعلم كونه مجازا فيه
وهذا أيضا ضعيف جدا لاحتمال أن يكون اللفظ حقيقة فيهما ويكون له بحسب إحدى الحقيقتين متعلق دون الأخرى والله أعلم
الباب السابع
في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ
اعلم أن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم ينبني على خمس احتمالات في اللفظأحدها احتمال الاشتراك
وثانيها احتمال النقل بالعرف أو الشرع
وثالثها احتمال المجاز
ورابعها احتمال الإضمار
وخامسها احتمال التخصيص
فإن قلت تركت احتمال الاقتضاء
قلت الاقتضاء اثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور ولا يتوقف عليه صحة اللفظ لغة كقول القائل اصعد السطح فإنه يقتضي نصب السلم لكن نصب السلم لا يتوقف عليه وجوب الصعود ولا يتوقف عليه صحة اللفظ
وإنما قلنا إن الخلل في الفهم لا بد وأن يكون لأحد هذه الخمس لأنه إذا انتقى احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد
واذا انتفى احتمال المجاز والاضمار كان المراد باللفظ ما وضع له فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم
واعلم أن التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أوجه لأنه يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية ثم بين
النقل والثلاثة الباقية ثم بين المجاز والوجهين الباقيين ثم بين الاضمار والتخصيص فكان المجموع عشرة
المسألة الأولى
إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل فالنقل أولى لأن عند النقل يكون اللفظ لحقيقة مفردة في جميع الأوقات إلا أنه في بعض الأوقات مفرد بالاضافة إلى معنى وفي بعض الأوقات مفرد بالاضافة إلى معنى آخر
والمشترك مشترك في الأوقات كلها فكان الأول أولى
فإن قبل لا بل الاشتراك أولى لوجوه
أحدها أن الاشتراك لا يقتضي نسخ وضع سابق والنقل يقتضيه
فالاشتراك أولى من النسخ على ما سيأتي بيانه فوجب أن يكون أولى مما لا يحصل إلا عند حصول النسخ
وثانيها أن الاشتراك ما أنكره أحد من العلماء المحققين والنقل انكره كثير من المحققين فالأول أولى
وثالثها أن الاشتراك إما أن يوجد مع القرينة أو لا يوجد مع القرينة
فإن حصلت القرينة معه عرف المخاطب المراد على التعيين
وإن لم توجد القرينة معه تعذر عليه العمل فيتوقف
وعلى التقديرين لا يخطئ في العمل
أما في النقل فربما لا يعرف النقل الجديد فيحمله على المفهوم الأول فيقع الغلط في العمل
ورابعها أن الاشتراك يمكن حصوله بوضع واحد فإن المتكلم قد يحتاج إلى التكلم بالكلام المجمل فيقول الواضع وضع هذا اللفظ لهذا ولهذا بالاشتراك
أما النقل فيتوقف على وضعه أولا ثم على نسخه ثانيا ثم على وضع جديد ولموقوف على أمر واحد أولى من الموقوف على أمور كثيرة
وخامسها أن السامع قد يسمع استعمال اللفظ في المعنى الأول وفي المعنى الثاني ولا يعرف أنه نقل من الأول إلى الثاني فيظنه مشتركا
فحينئذ يحصل فيه كل مفاسد الاشتراك مع مفاسد أخرى وهي جهله بكون اللفظ منقولا مع جميع المفاسد الحاصلة من النقل
وسادسها أن المشترك أكثر وجودا من المنقول فلو كانت المفاسد
الحاصلة من المشترك أكثر لكان الواضع قد رجح ما هو أكثر مفسدة على ما هو أقل مفسدة وهو غير جائز
والجواب أن الشرع إذا نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه الشرعي فلا بد أن يشتهر ذلك النقل وأن يبلغ إلى حد التواتر
وعلى هذا التقدير تزول المفاسد المذكورة والله أعلم
المسألة الثانية
إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى ويدل عليه وجهان
الأول أن المجاز أكثر في الكلام من الاشتراك والكثرة أمارة الظن في محل الشك
الثاني أن اللفظ الذي له مجاز إن تجرد من القرينة حمل على الحقيقة وان لم يتجرد عنها حمل على المجاز فلا يعرى على تعيين المراد والمشترك لا يفيد عين المراد عند العراء عن القرينة
فإن قيل بل الاشتراك أولى لوجوه
أحدها أن السامع للمشترك إن سمع القرينة معه علم المراد عينا فلا يخطئ
وإن لم يسمع توقف
وحينئذ لا يحصل إلا محذور واحد وهو الجهل بمراد المتكلم
أما اللفظ المحمول على المجاز بالقرينة فقد يسمع اللفظ ولا تسمع القرينة وحينئذ يحمل على الحقيقة فيحصل محذوران احدهما الجهل بمراد المتكلم والآخر اعتقاد ما ليس بمراد مرادا
وثانيها أن الاشتراك يحصل بوضع واحد على ما تقدم بيانه
وأما المجاز فيتوقف على وجود الحقيقة وعلى وجود ما يصلح مجازا وعلى العلاقة التي لأجلها يحسن جعله مجازا وعلى تعذر الحمل على الحقيقة
وما يتوقف على شيء واحد أولى مما يتوقف على أشياء
وثالثها أن اللفظ المشترك إذا دل دليل على تعذر أحد مفهوميه يعلم منه كون الآخر مرادا
والحقيقة إذا دل الدليل على تعذر العمل بها فلا يتعين فيها مجاز يجب حملها عليه
ورابعها أن اللفظ المشترك يفيد أن المراد هذا أو ذاك ودلالة اللفظ على هذا القدر من المعنى حقيقة لا مجاز والحقيقة
راجحة على المجاز فالاشتراك راجح على المجاز
وخامسها أن صرف اللفظ إلى المجاز يقتضي نسخ الحقيقة وحمله على الاشتراك لا يقتضي ذلك فكان الاشتراك أولى
وسادسها أن المخاطب في صورة الاشتراك يبحث عن القرينة لأن بدون القرينة لا يمكنه العمل فيبعد احتمال الخطأ
أما في صورة المجاز فقد لا نبحث عن القرينة لأن بدون القرينة يمكنه العمل فينصرف احتمال الخطأ
سابعها أن الفهم في صورة الاشتراك يحصل بأدنى القرائن لأن ذلك كاف في الرجحان
أما في صورة المجاز فلا يحصل رجحان المجاز إلا بقرينة
قوية جدا لأن أصالة الحقيقة لا تترك إلا لقرينة
والجواب أن هذه الوجوه معارضة بما ذكرناه في الباب المتقدم من فوائد المجازات
المسألة الثالثة
إذا وقع التعارض بين الاشتراك والإضمار فالإضمار أولى
لأن الاجمال الحاصل بسبب الاضمار مختص ببعض الصور والاجمال الحاصل بسبب الاشتراك عام في كل الصور فكان الاشتراك أخل بالفهم
فإن قلت الإضمار يفتقر إلى ثلاث قرائن قرينة تدل على أصل الاضمار وقرينة تدل على موضع الاضمار وقرينة
تدل على نفس المضمر والمشترك يفتقر إلى قرينة واحدة فكان الاضمار أكثر إخلالا بالفهم
قلت هذا لا ينفعكم لأن الإضمار يحتاج إلى ثلاث قرائن في صورة واحدة
والمشترك يحتاج إلى قرائن في صور متعددة فيبقى بعضها معارضا للبعض
على أن الإضمار من باب الايجاب والاختصار وهو من محاسن الكلام
قال عليه الصلاة و السلام أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا وليس المشترك كذلك
المسألة الرابعة
إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص فالتخصيص أولى لأن التخصيص خير من المجاز على ما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى
والمجاز خير من الاشتراك على ما تقدم فالتخصيص خير من الاشتراك لا محالة
المسألة الخامسة
إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز فالمجاز أولى
لأن النقل يحتاج إلى اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع وذلك متعذر أو متعسر والمجاز يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الحقيقة وذلك متيسر فكان المجاز أظهر
فان قلت ما ذكرته معارض بشيء آخر وهو أنه إذا ثبت النقل فهم كل أحد مراد المتكلم بحكم الوضع فلا يبقى خلل في الفهم
وفي المجاز إذا خرجت الحقيقة فربما خفي وجه المجاز أو تعدد طريقه فيقع خلل في الفهم
قلت ما ذكرتموه يعارضه شيئان آخران
أحدهما أن الحقيقة تعين على فهم المجاز لأن المجاز لا يصح إلا إذا كان بين الحقيقة والمجاز اتصال وفي صورة النقل اذا خرج المعنى الأول لقرينة لم يتعين اللفظ للمنقول إليه فكان المجاز أقرب إلى الفهم من هذا الوجه
الثاني أن في المجاز من الفوائد وليس في النقل ذلك فكان المجاز أولى
المسألة السادسة
اذا وقع التعارض بين النقل والاضمار فالاضمار أولى
والدليل عليه ما ذكرناه في أن المجاز أولى سواء بسواء
المسألة السابعة
اذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص فالتخصيص أولى لأن التخصيص خير من المجاز على ما سيأتي والمجاز خير من النقل على ما تقدم فالتخصيص خير من النقل
المسألة الثامنة
اذا وقع التعارض بين المجاز والاضمار فهما سواء لأن كل واحد منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر
وكما يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المضمر كذلك يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المجاز
فان قلت الحقيقة تعين على فهم المجاز فكانت أولى
قلت والحقيقة تعين على فهم الإضمار لأن حد الاضمار أن يسقط من الكلام شيء يدل عليه الباقي
المسألة التاسعة
إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص فالتخصيص أولى لوجهين
الأول أن في صورة التخصيص اذا لم يقف على القرينة يجريه على عمومه فيحصل مراد المتكلم وغير مراده
وفي صورة المجاز اذا لم يقف على القرينة يجريه على الحقيقة فلا يحصل مراد المتكلم ويحصل غير مراده
الثاني أن في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلا على كل الأفراد فاذا خرج البعض بدليل بقي معتبرا في الباقي فلا يحتاج فيه إلى تامل واستدلال واجتهاد
وفي صورة المجاز انعقد اللفظ دليلا على الحقيقة فاذا خرجت الحقيقة بقرينة احتيج في صرف اللفظ إلى المجاز إلى نوع تأمل واستدلال فكان التخصيص أبعد عن الاشتباه فكان أولى
المسألة العاشرة
إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص فالتخصيص أولى
والدليل عليه أن التخصيص خير من المجاز والمجاز والاضمار سيان فيلزم أن يكون التخصيص خيرا من الإضمار
فروع
الأول أنك ستعرف إن شاء الله تعالى أن النسخ تخصيص في الأزمان فحيث رجحنا التخصيص على الاشتراك فإنما أردنا به التخصيص في الأعيانأما لو وقع التعارض بين الاشتراك والنسخ فالاشتراك أولى لأن النسخ يحتاط فيه ما لا يحتاط في تخصيص العام ألا ترى أنه يجوز تخصيص العام بخبر الواحد والقياس ولا يجوز نسخ العام بهما
والفقه فيه أن الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل وبعد التخصيص لا يصير كالباطل فلا جرم يحتاط في النسخ ما لا يحتاط في التخصيص
الثاني أن اللفظ اذا دار بين التواطؤ والاشتراك فالتواطؤ أولى لأن مسمى اللفظ المتواطئ واحد والتعدد واقع في محاله ومسمى المشترك ليس بواحد والافراد أولى من الاشتراك على ما تقدم بيانه
الثالث إذا وقع التعارض بين أن يكون مشتركا بين علمين وبين معنيين كان جعله مشتركا بين علمين أولى لأن الاعلام إنما تنطلق على الأشخاص المخصوصة كزيد وعمرو
وأما أسماء المعاني فإنها تتناول المسمى في أي ذات كان فكان اختلال الفهم بجعله مشتركا بين علمين أقل فكان أولى
الرابع جعل اللفظ مشتركا بين علم ومعنى أولى من جعله مشتركا بين معنيين لأن الاختلال الحاصل عند الاشتراك بين العلم ولمعنى أقل مما عند الاشتراك بين المعنيين
الخامس اللفظ إذا تناول الشيء بجهة الاشتراك وبجهة التواطؤ كان اعتقاد أنه مستعمل بجهة التواطؤ أولى
و بيانه ان لفظ الأسود يتناول القار والزنجي بالتواطؤ ويتناول القار والرجل المسمى بالأسود بالاشتراك
فاذا وجد شخص أسود ومسمى بالأسود ثم أطلق عليه لفظ الأسود فاعتقاد أنه أطلق عليه هذا الاسم باعتبار
كونه ملونا أولى لأن الاطلاق بهذا الاعتبار اطلاق بجهة التواطؤ والاطلاق بجهة التلقيب اطلاق بجهة الاشتراك
والتواطؤ أولى من الاشتراك فكان ذلك أولى والله أعلم
الباب الثامن
في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها
وفيها مسائل
المسألة الأولىفي أن الواو العاطفة لمطلق الجمع
قال أبو علي الفارسي أجمع نحاة البصرة والكوفة على أنها للجمع المطلق
وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه أنها
للجمع المطلق وقال بعضهم إنها للترتيب
لنا وجوه
الأول أن الواو قد تستعمل فيما يمتنع حصول الترتيب فيه كقولهم تقاتل زيد وعمرو ولو قيل تقاتل زيد فعمرو أو تقاتل زيد ثم عمرو لم يصح
والأصل في الكلام الحقيقة فوجب أن يكون حقيقة في غير الترتيب فوجب ان لا يكون حقيقة في الترتيب دفعا للاشتراك
الثاني لو اقتضت الواو الترتيب لكان قوله رأيت زيدا وعمرا بعده تكريرا ولكان قوله رأيت زيدا وعمروا قبله متناقضا ولما لم يكن كذلك بالاجماع صح قولنا
فان قلت يجوز أن يكون الشيء بإطلاقه لا يفيد حكما ثم إذا أضيف إليه شيء آخر تغير عما كان عليه فقوله زيد في الدار يفيد الجزم فإذا أدخلت عليه الهمزة فقيل أزيد في الدار صار للاستخبار وبطل معنى الجزم
قلت حاصل هذا السؤال يرجع إلى أن قوله قبله أو بعده كالمعارض لمقتضى الواو إلا أن التعارض خلاف الأصل فالمفضي إليه وجب أن لا يكون
الثالث قوله تعالى في سورة البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وفي الأعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا والقصة واحدة وقوله تعالى واسجدي واركعي مع أن شرعها تقدم الركوع وقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وقوله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقوله تعالى والسارق والسارقة وقوله الزانية والزاني ففي شيء من هذه المواضع لا تفيد الترتيب
الرابع السيد إذا قال لعبده اشتر اللحم والخبز لم يفهم منه الترتيب
الخامس روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قيل له حين أراد السعي بين الصفا والمروة بأيهما نبدأ فقال ابدأوا بما بدأ الله به ولو كانت الواو للترتيب لما اشتبه ذلك على أهل اللسان ولما احتيج في بيان وجوب الابتداء من الصفا إلى الاستدلال بأنه مذكور أولا فوجب أن تقع به البداءة
السادس لو كانت الواو للترتيب لوجب أن القائل اذا
قال رأيت زيدا وعمرا ثم علم أنه رآهما معا أن يكون كاذبا وبالاجماع ليس كذلك
السابع قال أهل اللغة واو العطف في الأسماء المختلفة ك واو الجمع و بالتثنية في الأسماء المتماثلة فإنهم لما لم يتمكنوا من جمع الأسماء المختلفة بواو الجمع استعملوا فيها واو العطف
ولما كان قولهم جاءني الزيدان واجتمع الزيدون يفيد الاشتراك في الحكم ولا يفيد الترتيب فيه فكذا القول في واو العطف وواو الجمع يجوز أن يشتركا في إفادة الاشتراك
فإن قلت واو العطف وواو الجمع يجوز أن يشتركا في إفادة الاشتراك ثم واو العطف يختص بفائدة زائدة وهي الترتيب
قلت إنهم نصوا على أن فائدة احداهما عين فائدة
الأخرى وذلك ينفي الاحتمال المذكور
احتج المخالف بأمور
أحدها أن واحدا قام عند رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى ومن عصاهما فقد غوى فقال عليه الصلاة و السلام بئس الخطيب أنت هلا قلت ومن عصى الله ورسوله فقد غوى
ولو كانت الواو للجمع المطلق لما افترق الحل بين ما علمه الرسول صلى الله عليه و سلم وبين ما قال الرجل
وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع شاعرا يقول
... كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا
فقال له عمر رضي الله عنه لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك
وهذا يدل على أن التأخير في اللفظ يدل على التأخير في الرتبة
وروي أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لابن عباس رضي الله عنهما لم تأمرنا بالعمرة قبل الحج وقد قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وهم كانوا فصحاء العرب فثبت أنهم فهموا من الواو الترتيب
وثانيها إذا قال الزوج لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق وطالق طلقت طلقة واحدة ولم تلحقها الثانية ولولا أن الواو تقتضي الترتيب للحقتها الثانية كما أنها تطلق طلقتين إذا قال لها أنت طالق طلقتين
وثالثها إذا قال رأيت زيدا وعمرا فالترتيب يستدعي سببا والترتيب في الوجود صالح له فوجب جعله سببا له إلى أن يذكر الخصم سببا آخر
ورابعها أن الترتيب على سبيل التعقيب وضعوا له الفاء والترتيب على سبيل التراخي وضعوا له ثم
ومطلق الترتيب وهو القدر المشترك بين هذين النوعين معنى معقول أيضا فلا بد له من لفظ يدل عليه وما ذاك إلا الواو
فإن قلت الجمع المطلق معنى معقول أيضا فلا بد له من لفظ يدل عليه وما ذاك إلا الواو
قلت لما حصل التعارض وجب الترجيح وهو معنا وذلك لأنا لو جعلناه للترتيب المطلق كان معنى الجمع المطلق جزءا من المسمى ولازما له فجاز جعله مجازا فيه بسبب الملازمة
وأما لو جعلناه للجمع المطلق لم يكن الترتيب المطلق لازما له فلا يمكن جعله مجازا عنه لعدم الملازمة
و الجواب عن الأول أن الواو في قوله ومن عصى الله ورسوله لا تقتضي الترتيب لأن معصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه و سلم لا تنفك احداهما عن الأخرى فهذا بأن يدل على فساد قولكم أولى بل السبب فيه أن قوله ومن عصى الله ورسوله افراد لذكر الله تعالى عن
ذكر غيره فكان أدخل في التعظيم
وأما أثر عمر رضي الله عنه فهو محمول على أن الأدب أن يكون المقدم في الفضيلة مقدما في الذكر
وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فهو معارض بأمر ابن عباس إياهم بتقديم العمرة على الحج
وعن الثاني أن السبب في أن الطلقة الثانية لا تلحقها أن الطلاق الثاني ليس تفسيرا للكلام الأول والكلام الأول تام فبانت به
أما إذا قالت أنت طالق طلقتين فالقول الأخير في حكم البيان للأول فكان تمام الكلام بآخره
وعن الثالث أن الابتداء بالذكر لما كان دليلا على الترتيب لم تكن بنا حاجة إلى جعل الواو للترتيب
وعن الرابع أن ما ذكرتموه من الترجيح معارض بوجه آخر وهو أ الحاجة إلى التعبير عن المعنى الأعم أشد من الحاجة إلى التعبير عن المعنى الأخص لأنه حيث يحتاج إلى ذكر الأخص يحتاج إلى ذكر الأعم لا محالة ضمنا وقد يحتاج إلى ذكر الأعم حيث لا يحتاج إلى ذكر الأخص ألبتة فكانت الحاجة إلى ذكر الأعم أشد
المسألة الثانية
الفاء للتعقيب على حسب ما يصح
فلو قال دخلت بغداد فالبصرة أفاد التعقيب على ما يمكن لا على ما يمتنع
وإنما قلنا إنها للتعقيب لإجماع أهل اللغة عليه
ومنهم من استدل عليه بأنها لو لم تكن للتعقيب لما دخلت على الجزاء اذا لم يكن بلفظ الماضي والمضارع لكنها تدخل فيه فهي للتعقيب
بيان الملازمة أن جزاء الشرط قد يكون بلفظ الماضي كقوله من دخل داري أكرمته وقد يكون بلفظ المضارع كقوله من دخل داري يكرم وقد يكون لا بهاتين اللفظتين وحينئذ لا بد من ذكر الفاء كقوله من دخل داري فله درهم
وقول الشاعر
... من يفعل الحسنات ... الله يشكرها
فقد أنكره المبرد وزعم أن الرواية الصحيحة
... من يفعل الخير فالرحمن يشكره
وإذا وجب دخول الفاء على الجزاء وثبت أن الجزاء لا بد أن يحصل عقيب الشرط علمنا أن الفاء تقتضي التعقيب
و احتج المنازع بأمور
أحدها أن الفاء جاء في كتاب الله تعالى لا بمعنى
التعقيب في قوله تعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب والاسحات لا يقع عقيب الافتراء بل يتراخى إلى الآخرة وقال سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة مع أن ذلك قد لا يحصل عقيب المداينة
وثانيها أن الفاء قد تدخل على لفظ التعقيب ولو كانت الفاء للتعقيب لما جاز ذلك
وثالثها أن التعقيب يصح الإخبار به وعنه والفاء ليست كذلك فالفاء مغايرة للتعقيب
والجواب عن الكل أن ما ذكرتموه استدلال في مقابلة النص فلا يقدح في قولنا بل وجب حمل ما ذكروه أولا على المجاز وثانيا على التوكيد
وأما الثالث ففيه بحث دقيق ذكرناه في كتاب المحرر في دقائق النحو
المسألة الثالثة
لفظة في للظرفية محققا أو مقدرا
أما المحقق فكقولهم زيد في الدار
وأما المقدر فكقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل لتمكن المصلوب على الجذع تمكن الشيء في المكان
وقولنا فلان في الصلاة وشاك في هذه المسألة من هذا الباب
ومن الفقهاء من قال إنها للسببية كقوله عليه الصلاة و السلام في النفس المؤمنة مائة من الإبل وهو ضعيف لأن أحدا من أهل اللغة ما ذكر ذلك مع أن المرجع في هذه المباحث اليهم
المسألة الرابعة
المشهور أن لفظة من ترد
لابتداء الغاية كقولك سرت من الدار إلى السوق
وللتبعيض كقولك باب من حديد
وللتبيين كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان
وقد تجيء صلة في الكلام كقولك ما جاءني من رجل والحق عندي أنه للتمييز فقولك سرت من الدار إلى السوق ميزت مبدأ السير عن غيره وقولك باب من حديد ميزت الشيء الذي يكون منه الباب عن غيره وقوله عز و جل فاجتنبوا
الرجس من الأوثان ميزت الرجس الذي يجب اجتنابه عن غيره وكذلك قولك ما جاءني من أحد ميزت الذي نفيت عنه المجيء
وأما إلى فهي لانتهاء الغاية
وقيل إنها مجملة لأنها في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق تستدخل الغاية وفي قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل
تقتضي خروجها
وهذا ضعيف لأن هذه اللفظة إنما تكون مجملة لو كانت موضوعة لدخول الغاية وعدم دخولها على سبيل الاشتراك لكنا بينا أن اللفظ لا يجوز أن يكون مشتركا بالنسبة إلى وجود الشيء وعدمه
بل الحق أن الغاية إن كانت متميزة عن ذي الغاية بمفصل حسي كما في الليل والنهار وجب خروجها وان لم تكن متميزة عنها بمفصل حسي كما في اليد والمرفق وجب دخولها لأنه ليس بعض المقادير أولى من بعض فليس تقدير القدر الذي يجوز إخراجه من المرفق عن وجوب الغسل بقدر معين أولى من تقديره بما هو أزيد أو أنقص
المسألة الخامسة
الباء اذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه كقوله تعالى وامسحوا برءوسكم
تقتضي التبعيض خلافا للحنفية
وأجمعنا على أنها إذا دخلت على فعل لا يتعدى بنفسه كقولك كتبت بالقلم ومررت بزيد فإنها لا تقتضي إلا مجرد الالصاق
لنا
أنا نعلم بالضرورة الفرق بين أن يقال مسحت يدي
بالمنديل وبالحائط وبين أن يقال مسحت المنديل والحائط في أن الأول يفيد التبعيض والثاني يفيد الشمول
و احتج المخالف بأمرين
الأول أن القائل إذا قال مررت بزيد و كتبت بالقلم و طفت بالبيت عقلوا منه الصاق الفعل بالمفعول به فدل على أن مقتضى اللفظ ليس إلا الصاق الفعل بالمفعول به
الثاني أن أبا الفتح ابن جني ذكر أن الذي يقال من أن الباء للتبعيض شيء لا يعرفه أهل اللغة
و الجواب عن الأول أن قولهم مررت بزيد
وكتبت بالقلم إنما أفاد ذلك لأنه لا يتعدى بنفسه فلا يجوز أن يقال مررت زيدا وكتبت القلم فلذلك أفاد ما قالوه بخلاف ما ذكرنا
وأما الطواف فهو عبارة عن الدوران حول جميع البيت ولهذا لا يسمى من دار ببعضه طائفا بخلاف ما نحن فيه فإن من مسح بعض الرأس يسمى ماسحا
وعن الثاني أن الشهادة على النفي غير مقبولة فلنا أن نخطئ ابن الجني بالدليل الظاهر الذي ذكرناه
المسألة السادسة
لفظة إنما للحصر خلافا لبعضهم
لنا ثلاثة أوجه
أحدها أن الشيخ ابا علي الفارسي حكى ذلك في كتاب الشيرازيات عن النحاة وصوبهم فيه وقولهم حجة
وثانيها التمسك بقول الأعشى
... ولست بالأكثر منهم حصى ... وإنما العزة للكاثر
وبقول الفرزدق
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي ...
ولو لم تحمل إنما ها هنا على الحصر لما حصل مقصود الشاعر
وثالثها أن كلمة إن تقتضي الاثبات وما تقتضي النفي فعند تركيبها يجب أن يبقى كل واحد منهما على الأصل لأن الأصل عدم التغيير
فإما أن نقول كلمة إن تقتضي ثبوت عين المذكور وكلمة ما تقتضي نفي المذكور وهذا هو الحصر وهو المراد
واحتج المخالف بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وأجمعنا على أن من ليس كذلك فهو مؤمن أيضا
والجواب
أنه محمول على المبالغة
الباب التاسع
في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه و سلم على الأحكاموفيه مسائل
المسألة الأولىفي أنه لا يجوز أن يتكلم الله تعالى بشيء ولا يعني به شيئا
والخلاف فيه مع الحشوية
لنا وجهان
أحدهما أن التكلم بما لا يفيد شيئا هذيان وهو نقص والنقص على الله تعالى محال
وثانيها أن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيانا وذلك لا يحصل بما لا يفهم معناه
واحتج المخالف بأمور
أحدها أنه جاء في القرآن ما لا يفيد كقوله كهيعص وما يشبه وقوله كأنه رءوس الشياطين وقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فقوله عشرة كاملة لا يفيد فائدة زائدة وقوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وقوله لا تتخذوا إليهن
اثنين
وثانيها أن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله واجب ومتى كان ذلك كذلك لزم القول بأن الله تعالى قد تكلم بما لا يفهم منه شيء
بيان الأول أننا لو لم نقف هناك بل وقفنا على قوله والراسخون في العلم فاذا ابتدأنا بقوله يقولون آمنا كان المراد منه قائلين آمنا به كل من عند ربنا ويصير ذلك عائدا إلى المذكورات السالفة فيصير المعنى كأن الله تعالى قال الراسخون في العلم قالوا آمنا به كل من عند ربنا وذلك غير جائز على الله تعالى
فثبت أن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله واجب
وإذا ثبت ذلك ظهر أنا لا نعلم تأويل المتشابهات
وثالثها أن الله تعالى خاطب الفرس بلغة العرب مع أنهم لا يفهمون شيئا منها وإذا جاز ذلك فليجز مطلقا
والجواب عن الأول أن لأهل التفسير فيها أقوالا مشهورة والحق فيها أنها أسماء السور
وأما روس الشياطين فقيل إن العرب كانوا يستقبحون ذلك
المتخيل ويضربون به المثل في القبح
وأما قوله عشرة كاملة فذلك للتأكيد وهو الجواب أيضا عن سائر الآيات
وعن الثاني أن موضع الوقف قوله والراسخون في العلم وما ذكروه من الاشكال فغايته أنه عام خص منه البعض بدليل العقل لامتناع عود ذلك الضمير إلى الله تعالى
وعن الثالث أن للفرس طريقا إلى معرفة الخطاب بالرجوع إلى العرب
المسألة الثانية
في أنه لا يجوز أن يعني بكلامه خلاف ظاهره ولا يدل عليه ألبتة
والخلاف فيه مع المرجئة
لنا
أن اللفظ الخالي عن البيان أبدا يكون بالنسبة إلى غير ظاهره مهملا وقد بينا أن التكلم بالمهمل غير جائز على الله تعالى
فان قيل ان عنيت بالمهمل ما لا فائدة فيه ألبتة فلا نسلم أن الأمر كذلك لأنه تعالى اذا تكلم بما ظاهره يقتضي الوعيد مع أنه لا يريد ذلك حصل منه تخويف الفساق والتخويف يمنعهم من الاقدام فقد حصلت هذه الفائدة
وإن عنيت به أنه لا يحصل منه فائدة الإفهام فهو مسلم لكن لم قلت إن ما يكون كذلك فإنه غير جائز على الله تعالى فإن هذا أول المسألة
والجواب
لو فتحنا هذا الباب لما بقي الاعتماد على شيء من خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه و سلم لأنه ما من خبر إلا ويحتمل أن يكون المقصود منه أمرا وراء الإفهام ومعلوم أن ذلك ظاهرا الفساد والله أعلم
المسألة الثالثة
في أن الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطع أم لا
منهم من أنكره وقال إن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدمات ظنية والمبني على المقدمات الظنية ظني فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظن
وإنما قلنا إنه مبني على مقدمات ظنية لأنه مبني على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز
والنقل والاضمار والتخصيص والتقديم والتأخير والناسخ والمعارض وكل ذلك أمور ظنية
أما بيان أن نقل اللغات ظني فلأن المرجع فيه إلى أئمة اللغة وأجمع العقلاء على أنهم ما كانوا بحيث يقطع بعصمتهم فنقلهم لا يفيد إلا الظن وتمام الكلام في هذا المقام قد تقدم
وأما النحو والتصريف فالمرجع في اثباتهما إلى أشعار المتقدمين إلا أن التمسك بتلك الأشعار مبني على مقدمتين ظنيتين
احداهما
أن هذه الأشعار رواها الآحاد ورواية الآحاد لا تفيد إلا الظن
وأيضا إن الذين رووها روايتهم مرسلة لا مسندة والمرسل غير مقبول عند الأكثرين إذا كان خبرا عن
رسول الله صلى الله عليه و سلم فكيف اذا كان خبر عن شخص لا يؤبه له ولا يلتفت إليه
وثانيهما
هب أنه صح هذا الشعر عن هذا الشاعر لكن لم قلت إن ذلك الشاعر لا يلحن
أقصى ما في الباب أنه عربي لكن العربي قد يلحن في العربية كما أن الفارسي قد يلحن كثيرا في الفارسية
والذي يؤيد هذا الاحتمال أن الأدباء لحنوا أكابر شعراء الجاهلية
كامريء القيس وطرفة ولبيد واذا كانوا معترفين بأنهم قد لحنوا فكيف يجوز التعويل في تصحيح الألفاظ واعرابها في قولهم
ذكر القاضي أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني في الكتاب الذي صنفه في الوساطة بين المتنبي وخصومه
أن امرأ القيس أخطأ في قوله
... يا راكبا بلغ اخواننا ... من كان من كندة أو وائل ...
فنصب بلغ
وفي قوله
... فاليوم اشرب غير مستحقب ... إثما من الله ولا واغل
فسكن أشرب
وقوله
... لها متنان خظاتا كما ... أكب على ساعديه النمر
فأسقط النون من خظاتا بغير اضافة
وقول لبيد
... تراك أمكنة إذا لم أرضها ... أو يرتبط بعض النفوس حمامها
فسكن يرتبط ولا عمل للم فيه
وقوله طرفة
... قد رفع الفخ فماذا تحذري ...
فحذف النون
وقول الأسدي
كنا نرقعها فقد مزقت ... واتسع الخرق على الراقع
فسكن نرقع
وقول الفرزدق
... وعض زمان يا ابن مروان لم يدع ... من المال إلا مسحتا أو مجلف
فضم مجلف
وقول ذي الخرق الطهوي
... يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا ... إلى ربنا صوت الحمار اليجدع
فأدخل الألف واللام على الفعل
وقول رؤية
... أقفرت الوعثاء والعثاعث ... من بعدهم والبرق البوارث
وإنما هي البرارث جمع برث وهي الأماكن السهلة من الأرض
وقوله أيضا
... قد شفها اللوح بمازول ضيق ...
ففتح الياء
فهذه وأمثالها كثيرة
وجرى بين الفرزدق وبين عبد الله بن اسحاق الحضرمي في إقوائه وفي لحنه في قوله
... فلو كان عبد الله مولى هجوته ... ولكن عبد الله مولى مواليا ...
ففتح الياء من موالي في حال الجر
وجرى له مع عنبسة الفيل النحوي حتى قال فيه
لقد كان في معدان للفيل شاغل ... لعنبسة الراوي علي القصائدا ...
وكان القدماء يتبعون أشعار الأوائل من لحن وغلط وإحالة وفساد معنى
وقال الأصمعي في الكميت إنه جرمقاني من جرامقة
الشام لا يحتج بشعره
وأنكر من شعر الطرماح ولحن ذا الرمة
ثم ان القاضي علي بن عبد العزيز طول في هذا المعنى وفي هذا القدر كفاية ومن أراد الاستقصاء فليطالع ذلك الكتاب
وعند هذا نقول المرجع في صحة اللغات والنحو والتصريف إلى هؤلاء الأدباء واعتمادهم على تصحيح الصحيح منها وإفساد الفاسد على أقوال هؤلاء الأكابر من شعراء الجاهلية والمخضرمين واذا كان الأدباء قدحوا فيهم وبينوا لحنهم وخطأهم في
اللفظ والمعنى والإعراب ف مع هذا كيف يمكن الرجوع إلى قولهم والاستدلال بشعرهم
أقصى ما في الباب أن يقال هذه الأغلاط نادرة والنادر لا عبرة به لكنا نقول النادر لا يقدح في الظن لكن لا شك أنه يقدح في اليقين لقيام الاحتمال في كل واحد من تلك الألفاظ والاعرابات أنه من ذلك اللحن النادر
فثبت أن المقصد الأقصى في صحة اللغة والنحو والتصريف الظن
الظن الثاني عدم الاشتراك فإن بتقدير الاشتراك يجوز أن يكون مراد الله تعالى من هذا الكلام غير هذا المعنى الذي
اعتقدناه لكن نفي الاشتراك ظني
الظن الثالث عدم المجاز فإن حمل اللفظ على حقيقته إنما يتعين لو لم يكن محمولا على مجازه لكن عدم المجاز مظنون
الظن الرابع أنه لا بد من عدم النقل فإن بتقدير أن يقال الشرع أو العرف نقله من معناه اللغوي إلى معنى آخر كان المراد هو المنقول إليه لا ذلك الأصل
الظن الخامس أنه لا بد من عدم الإضمار فانه لو كان الحق هو لكان المراد هو ذلك الذي يدل عليه اللفظ بعد الإضمار لا هذا الظاهر
الظن السادس عدم التخصيص وتقريره ظاهر
الظن السابع عدم الناسخ ولا شك في كونه محتملا في الجملة وبتقدير وقوعه لم يكن الحكم ثابتا
الظن الثامن عدم التقديم والتأخير ووجهه ظاهر
الظن التاسع نفي المعارض العقلي فإنه لو قام دليل قاطع عقلي على نفي ما أشعر به ظاهر النقل فالقول بهما محال لاستحالة وقوع النفي والاثبات والقول بارتفاعهما محال لاستحالة عدم النفي والاثبات
والقول بترجيح النقل على العقل محال لأن العقل أصل النقل فلو كذبنا العقل لكنا كذبنا أصل النقل ومتى كذبنا
أصل النقل فقد كذبنا النقل
فتصحيح النقل بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل فعلمنا أنه لا بد من ترجيح دليل العقل
فإذا رأينا دليلا نقليا فإنما يبقى دليلا عند السلامة عن هذه الوجوه التسعة ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها إلا إذا قيل بحثنا واجتهدنا فلم نجدها لكنا نعلم أن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يفيد إلا الظن
فثبت أن التمسك بالأدلة النقلية مبني على مقدمات ظنية والمبني على الظني ظني
وذلك لا شك فيه فالتمسك بالدلائل النقلية لا يفيد إلا الظن
فإن قلت المكلف إذا سمع دليلا نقليا فلو حصل فيه شيء من هذه المطاعن لوجب في حكمه الله أن يطلعه على ذلك
قلت القول بالوجوب على الله تعالى مبني على قاعدة الحسن والقبح العقليين وقد تقدم القول فيها
سلمنا ولكننا نقطع بأنه لا يجب على الله تعالى أن يطلعه على ذلك لما أنا نجد كثيرا من العلماء يسمعون آية أو خبرا مع أنهم لا يعرفون ما في نحوها ولغتها وتصريفها من الاحتمالات التسعة التي ذكرناها وانكار ذلك مكابرة ولو كان ذلك
واجبا لما كان الأمر كذلك فعلمنا ضعف هذا العذر
وفيه وجوه أخر من الفساد ذكرناها في الكتب الكلامية
واعلم أن الانصاف أنه لا سبيل إلى استفاد ة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين سواء كانت
تلك القرائن مشاهدة أو كانت منقولة الينا بالتواتر
المسألة الرابعة
في كيفية الاستدلال بالخطاب
الخطاب إما أن يدل على الحكم بلفظه أو بمعناه أو لا يكون كذلك ولكنه بحيث لو ضم إليه شيء آخر لصار المجموع دليلا على الحكم
القسم الأول ما يدل عليه بلفظه
وقد عرفت أنه يجب حمل اللفظ على الحقيقة وعرفت أن الحقيقة ضربان أصلية وهي اللغوية وطارئة وهي العرفية والشرعية
فإن كان الخطاب مستعملا في اللغة في شيء وفي العرف
في شيء آخر ولم يخرج بالعرف عن أن يكون حقيقة في المعنى اللغوي فإنه يكون مشتركا بينهما
وإن صار مجازا في المعنى اللغوي وجب حمله على العرفي لأنه هو المتبادر إلى الفهم ويجب مثل هذا في الاسم المنقول إلى معنى شرعي
فالحاصل أن الخطاب يجب حمله على المعنى الشرعي ثم العرفي ثم المعنى اللغوي الحقيقي ثم المجاز
فإن خاطب الله تعالى طائفتين بخطاب هو حقيقة عند احداهما في شيء وعند الأخرى في شيء آخر وجب أن تحمله كل واحدة منهما على ما تتعارفه والالزم أن يقال إن
الله تعالى خاطبه بغير ما هو ظاهر عنده مع عدم القرينة والله أعلم بالصواب
القسم الثاني
ما يدل عليه بمعناه وهو الدلالة الالتزاميةوقد ذكرنا في الباب الثاني أقسام الدلالة الالتزامية
القسم الثالث
ما يكون بحيث لو ضم إليه شيء آخر لصار المجموع دليلا على الحكمفنقول ذلك الذي يضم إليه إما أن يكون دليلا شرعيا وهو نص أو إجماع أو قياس
أو يكون ذلك بشهادة حال المتكلم
فهذه وجوه أربعة
أحدها أن ينضم إلى النص آخر فيصير مجموعهما دليلا على
الحكم وله مثالان
الأول أن يدل أحد النصين على إحدى المقدمتين والثاني على الثانية فيحصل المطلوب كقولنا تارك المأمور عاص لقوله تعالى أفعصيت امري والعاصي يستتحق العقاب لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها
الثاني أن يدل أحد النصين على ثبوت الحكم لشيئين ويدل النص الآخر على أن بعض ذلك لأحدهما فوجب القطع بأن باقي الحكم ثابت للثاني كقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فهذا يدل على أن مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين
كاملين فهذا يدل على أن مدة الرضاع سنتان فيلزم أن تكون مدة الحمل ستة أشهر
وثانيها أن يضم إلى النص اجماع كما إذا دل النص على أن الخال لا يرث ودل الاجماع على أن الخالة بمثابته
وثالثها أن يضم إلى النص قياس كما إذا دل النص على حرمة الربا في البر ودل القياس على أن التفاح بمثابته
ورابعها أن يضم إلى النص شهادة حال المتكلم كما إذا كان كلام الشرع مترددا بين الحكم العقلي والشرعي
فحمله على الشرعي أولى لأن النبي صلى الله عليه و سلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان ما يستقل العقل بإدراكه
هذا إذا كان الخطاب مترددا بينهما
أما إذا كان ظاهر ه مع أحدهما لم يصح الترجيح بذلك والله أعلم
المسألة الخامسة
في الخطاب الذي لا يمكن حمله على ظاهره
هذا الخطاب إما أن يكون خاصا أو عاما
فان كان خاصا وكان حقيقة في شيء ثم وجدت قرينة تصرفه عنه فإما أن تدل القرينة على أن المراد ليس ظاهره أو تدل على أن المراد غير ظاهره أو على أن المراد ظاهره وغير ظاهره معا
فإن دل على أن المراد ليس ظاهره خرج الظاهر عن أن يكون مرادا فيجب حمله على المجاز
ثم إن المجاز إما أن يكون واحدا أو أكثر
فإن كان واحدا حمل اللفظ عليه من غير افتقار إلى دلالة أخرى صونا للكلام عن الإلغاء
وإن كان أكثر من واحد فإما أن يدل دليل في واحد معين على أنه مراد أو على أنه ليس بمراد أو لا يدل الدليل في واحد معين لا بكونه مرادا ولا بكونه غير مراد
فإن دل الدليل على أنه مراد قضي به
وإن دل الدليل على أنه غير مراد فإن لم يبق إلا وجه واحد حمل عليه
وإن بقي أكثر من واحد كان القول فيه كما إذا لم يوجد الدليل على كونه مرادا ولا على كونه غير مراد وهذا هو القسم الثالث
فنقول
وجوه المجاز إما أن تكون محصورة أو غير محصورة
فإن لم تكن محصورة فقال القاضي عبد الجبار لا بد من دلالة تدل على المراد لأنه لا يجوز أن يريدها أجمع مع تعذر حصرها علينا
قال أبو الحسين ولقائل أن يقول إنه أرادها كلها على البدل لأن ذلك ممكن مع فقد الدلالة ومع فقد الحصر فإنه تعالى لو أوجب علينا ذبح بقرة فإنا نكون مخيرين في ذبح أي بقرة شئنا وإن لم يمكنا حصر البقر
فأما من لا يجيز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان فيجيئ على مذهبه أنه لا بد من دلالة تدل على المراد بعينه لأن اللفظ ما وضع للتخيير
و أما إن كانت وجوه المجاز محصورة
فإن كان البعض أقوى من الباقي حمل على الأقوى رعاية لزيادة القوة
وإن تساوت حمل اللفظ عليها بأسرها على البدل
أما على الكل فلأنه ليس حمل الخطاب على البعض أولى من الباقي
وأما على البدل فلأن الخطاب ليس بعام حتى يحمل على الجميع
هذا على قول من يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه
فأما من لا يجوزه فإنه يقول لا بد من البيان
القسم الثاني
وهو أن يدل الدليل على أن غير الظاهر مراد فذلك الدليل إما أن يعين ذلك الغير أو لا يعينه
فإن عينه وجب حمله عليه وإن لم يعينه فالقول فيه كما في القسم الأول
القسم الثالث
وهو أن يدل دليل على أن ظاهر الخطاب مراد وغير ظاهره مرادفإن كان ذلك الغير معينا وجبت الحمل عليه فيكون اللفظ موضوعا لهما من جهة اللغة أو من جهة الشرع أو تكلم بالكلمة مرتين
وان لم يتعين ذلك الغير فالكلام فيه كما في القسم الأول
أما إن كان الخطاب عاما فإن تجرد عن القرينة حمل على العموم وان لم يتجرد فهذا يقع على وجوه
أحدها أن تدل القرينة على أن المراد ظاهره وغير ظاهره معا
فان كان ذلك الغير معنيا حمل اللفظ عليه على التفصيل المذكور
وان لم يكن معينا فالكلام فيه كما في الخاص إذا دلت الدلالة على أن المراد غير ظاهره
وثانيها أن يدل الدليل على أن المراد ليس ظاهره و أن المراد غير ظاهره فها هنا لا بد أن يوجد الدليل على التعيين لأنه إذا لم يكن المراد ظاهره جاز أن يكون المراد بعض ما يتناوله وجاز أن يكون المراد شيئا آخر لم يتناوله الخطاب فاذا لم يصح اجتماعهما فلا بد من دليل يعين المراد
وثالثها أن يدل الدليل على أن بعضه مراد وهذا لا يقتضي خروج البعض الآخر عن أن يكون مرادا لأنه لا ينافي ذلك
فان دل على أن المراد هو البعض خرج البعض الآخر عن كونه مرادا لأن ذلك اخبار بأن ذلك البعض هو كمال المراد
ورابعها أن يدل الدليل على أن بعضه ليس بمراد وحينئذ يخرج عن كونه مرادا ويبقى ما عداه تحت ذلك الخطاب والله أعلم
المسألة السادسة
في أن ثبوت حكم الخطاب اذا تناوله على وجه المجاز لا يدل على أنه مراد بالخطاب
مثاله قوله تعالى أو لامستم النساء فإن قيام الدلالة على وجوب التيمم على المجامع وهو الذي تناوله اسم الملامسة على طريق الكناية هل يدل على أنه هو المراد بالآية
فذهب الكرخي وأبو عبدالله البصري إلى أنه واجب
وعندنا أنه ليس بواجب
لنا
المقتضى لاجراء الآية على ظاهرها موجود والمعارض الموجود وهو ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله على وجه المجاز لا يصلح معارضا له لاحتمال ثبوته بدليل آخر أوجب اجراء الآية على ظاهرها
واحتجوا بأن ثبوت الحكم في صورة المجاز لا بد له من دليل ولا دليل سوى هذا الظاهر وإلا لنقل
واذا حمل الظاهر على مجازه وجب أن لا يحمل على الحقيقة لامتناع استعمال اللفظ في مجازه وحقيقته معا
والجواب
لا نسلم أنه لا دليل سوى هذا الظاهر
قوله لو وجد لنقل
قلنا لعلهم استغنوا بالاجماع عن نقله والله أعلم
الكلام في الأوامر والنواهي
وهو مرتب على مقدمة وثلاثة مسائلأما المقدمة ففيها مسائل
المسألة الأولى
اتفقوا على أن لفظة الأمر حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيرهفزعم بعض الفقهاء أنه حقيقة في الفعل أيضا
والجمهور على أنه مجاز فيه
وزعم أبو الحسين البصري أنه مشترك بين القول المخصوص وبين الشيء وبين الصفة وبين الشأن والطريق
والمختار أنه حقيقة في القول المخصوص فقط
لنا
إنا أجمعنا على أنه حقيقة في القول المخصوص فوجب أن لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراكومن الناس من استدل على أنه ليس حقيقة في الفعل بأمور
أحدها
لو كان لفظ الأمر حقيقة في الفعل لاطرد فكان يسمى الأكل أمرا والشرب أمراوثانيها
ولكان يشتق للفاعل اسم الآمر وليس كذلك لأن من قام أو قعد لا يسمى آمراوثالثها
أن للأمر لوازم ولم يوجد شيء منها في الفعل فوجب أن لا يكون الأمر حقيقة في الفعل بيان الأول أن الأمر يدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي وضده النهي ويمنع منه الخرس والسكوت لأنهم يستهجنون في الأخرس والساكت أن يقال وقع منه أمر
وعدوا الأمر مطلقا من أقسام الكلام كما عدوا الخبر مطلقا منه وكل ذلك ينافي كون الأمر حقيقة إلا في القول
ورابعها
أنه يصح نفي الأمر عن الفعل فيقال إنه ما أمر به ولكن فعلهوهذه الوجوه ضعيفة
أما الأول فلأنا لا نسلم أن من شأن الحقيقة الاطراد وقد تقدم بيان هذا المقام
سلمناه لكن لا نسلم أنه لا يصح أن يقال للأكل
والشرب أمر
وعن الثاني ما تقدم في باب المجاز أن الاشتقاق غير واجب في كل الحقائق
وعن الثالث أن العرب إنما حكموا بتلك الصفات في الأمر بمعنى القول فإن ادعيتم أنهم حكموا به في كل ما يسمى أمرا فهو ممنوع
وعن الرابع لا نسلم أنهم جوزوا نفيه مطلقا
واحتج القائلون بأنه حقيقة في الفعل بوجهين
أحدهما
أن أهل اللغة يستعملون لفظة الأمر في الفعل وظاهر الاستعمال الحقيقةبيان الاستعمال القرآن والشعر والعرف
أما القرآن فقوله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور والمراد منه العجائب التي فعلها الله تعالى وقوله تعالى أتعجبين من أمر الله وأراد به الفعل وقوله وما أمر فرعون برشيد وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وقوله تجري في البحر بأمره وقوله مسخرات بأمره
وأما الشعر فقوله ... لأمر ما يسود من يسود
وأما العرف فقول العرب في خبر الزباء لأمر ما جدع قصير أنفه
ويقولون أمر فلان مستقيم وأمره غير مستقيم وإنما يريدون طرائقه وأفعاله وأحواله
ويقولون هذا أمر عظيم كما يقولون خطب عظيم ورأيت من فلان أمرا هالني
وأما أن الأصل في الإطلاق الحقيقة فقد تقدم
وثانيهما
أنه قد خولف بين جمع الأمر بمعنى القول وبين جمعه بمعنى الفعل فيقال في الأول أوامر وفي الثاني أمور والاشتقاق علامة الحقيقة واحتج أبو الحسين على قوله بأن من قال هذا أمر لم يدر السامع أي هذه الأمور أراد
فإذا قال هذا أمر بالفعل أو أمر فلان مستقيم أو تحرك هذا الجسم لأمر أو جاء زيد لأمر عقل السامع من الأول القول ومن الثاني الشأن ومن الثالث أن الجسم تحرك لشيء ومن الرابع أن زيدا جاء لغرض من الأغراض وتوقف الذهن عند السماع يدل على أنه متردد بين الكل
والجواب عن الأول
أنا لا نسلم استعمال هذا اللفظ في الفعل من حيث إنه فعل أما قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا فلم لا يجوز أن يكون المراد منه القول أو الشأن والفعل يطلق عليه اسم الأمر لعموم كونه شأنا لا لخصوص كونه فعلا
وكذا الجواب عن الآية الثانية
وأما قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد فلم لا يجوز أن يكون المراد هو القول بل الأظهر ذلك لما تقدم من قوله فاتبعوا أمر فرعون أي أطاعوه فيما أمرهم به
سلمنا أنه ليس المراد منه القول فلم لا يجوز أن يكون المراد شأنه وطريقه
وأما قوله تعالى وما أمرنا إلا واحده فنقول
لا يجوز إجراء اللفظ على ظاهره أما أولا فلأنه يلزم أن يكون فعل الله تعالى واحدا وهو باطل
وأما ثانيا فلأنه يقتضي أن يكون كل فعل الله تعالى لا يحدث إلا كلمح بالبصر في السرعة ومعلوم أنه ليس كذلك
وإذا وجب صرفه عن الظهر علمنا أن المراد منه تعالى من شأنه أنه إذا أراد شيئا وقع كلمح البصر
وأما قوله تجري في البحر بأمره مسخرات بأمره فلا يجوز حمل الأمر هاهنا
على الفعل لأن الجري والتسخير إنما حصلا بقدرته لا بفعله فوجب حمله على الشأن والطريق
سلمنا أن لفظ الأمر مستعمل في الفعل فلم قلت إنه حقيقة فيه
فإن قلتم لأن الأصل في الكلام الحقيقة قلنا والأصل عدم الاشتراك على ما تقدم
وقد تقدم بيان أنه إذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى
والجواب عن الثاني
لم لا يجوز أن تكون الأمور جمعا للأمر بمعنى الشأن لا بمعنى الفعل سلمناه لكن لا نسلم أن الجمع من علامات الحقيقة على ما تقدم بيانه
فأما ما احتج به أبو الحسين فهو بناء على تردد الذهن عند سماع تلك اللفظة بين تلك المعاني وذلك ممنوع فإن الذي يزعم أنه حقيقة في القول يمنع من ذلك التردد اللهم إلا إذا وجدت قرينة مانعة من حمل اللفظ على القول كما إذا استعمل في موضع لا يليق به القول فحينئذ ذلك قرينة في أن المراد منه غير القول والله أعلم
المسألة الثانية
ذكروا في حد الأمر بمعنى القول وجهينأحدهما
ما قاله القاضي أبو بكر وارتضاه جمهور الأصحاب أنه هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور بهوهذا خطأ أما أولا فلأن لفظتي المأمور والمأمور به مشتقتان من الأمر فيمتنع تعريفهما إلا بالأمر فلو عرفنا الأمر بهما لزم الدور
وأما ثانيا فلأن الطاعة عند أصحابنا موافقةالأمر وعند المعتزلة موافقة الإرادة فالطاعة على قول أصحابنا لا يمكن تعريفها إلا بالأمر فلو عرفنا الأمر بها لزم الدور
وثانيهما
ما ذكره أكثر المعتزلة وهو أن الأمر هو قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامهوهذا خطأ من وجوه
الأول
أنا لو قدرنا أن الواضع ما وضع لفظة افعل لشيء أصلا حتى كانت هذه اللفظة من المهملات ففي تلك الحالة لو تلفظ الإنسان بها مع من دونه لا يقال فيه إنه أمرولو أنها صدرت عن النائم والساهي أو على سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقا أو على سبيل الحكاية لا يقال فيه إنه أمر
ولو أنا قدرنا أن الواضح وضع بإزاء معنى الأمر لفظ إفعل وبإزاء معنى الخبر لفظ إفعل لكان المتكلم بلفظ إفعل آمرا والمتكلم بلفظ إفعل مخبرا
فعلمنا أن تحديد ماهية الأمر بالصيغة المخصوصة باطل
الثاني
أن المطلوب تحديد ماهية الأمر من حيث إنه أمر وهي حقيقة لا تختلف باختلاف اللغات فإن التركي قد يأمر وينهى وما ذكروه لا يتناول إلا الألفاظ العربيةفإن قلت قوله أو ما يقوم مقامه احتراز عن هذين الإشكالين اللذين ذكرتهما
قلت قوله أو ما يقوم مقامه يعني به كونه قائما مقامه في الدلالة على كونه طالبا للفعل أو يعني به شيئا آخر
فإن كان المراد هو الثاني فلا بد من بيانه وإن كان
المراد هو الأول صار معنى حد الأمر هو قول القائل لمن دونه إفعل أو ما يقوم مقامه في الدلالة على طلب الفعل
وإذا ذكرناه على هذا الوجه كان قولنا الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل كافيا وحينئذ يقع التعرض لخصوص صيغة إفعل ضائعا
الثالث
أنا سنبين إن شاء الله تعالى أن الرتبة غير معتبرة وإذا ثبت فساد هذين الحدين فنقولالصحيح أن يقال الأمر طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء
ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الأخير
المسألة الثالثة
في ماهية الطلباعلم أن تصور ماهية الطلب حاصل لكل العقلاء على سبيل الاضطرار فإن من لم يمارس شيئا من الصنائع العلمية ولم يعرف الحدود والرسوم قد يأمر وينهى ويدرك تفرقة بديهية بين طلب الفعل وبين طلب الترك وبينهما وبين المفهوم من الخبر ويعلم أن ما يصلح جوابا لأحدهما لا يصلح جوابا للآخر
ولولا أن ماهية الطلب متصورة تصورا بديهيا وإلا لما صح ذلك
ثم نقول معنى الطلب ليس نفس الصيغة لأن ماهية الطلب لا تختلف باختلاف النواحي والأمم وكان يحتمل في الصيغة
التي وضعوها للخبر أن يضعوها للأمر وبالعكس فماهية الطلب ليست نفس الصيغة ولا شيئا من صفاتها بل هي ماهية قائمة بقلب المتكلم تجري مجرى علمه وقدرته وهذه الصيغ المخصوصة دالة عليها
ويتفرع على هذه القاعدة مسائل
المسألة الأولى
أن تلك الماهية عندنا شيء غير الإرادةوقالت المعتزلة هي إرادة المأمور به
لنا وجوه أولها
أن الله تعالى ما أراد من الكافر الإيمان وقد أمره به فدل على أن حقيقة الأمر غير حقيقة الإرادة وغير مشروطة بهاوإنما قلنا إنه تعالى ما أراد منه الإيمان لوجهين
أحدهما
أنه تعالى لما علم منه أنه لا يؤمن فلو آمن لزم انقلاب علمه جهلا وذلك محال والمفضي إلى المحال محال فصدور الإيمان منه محالوالله تعالى عالم بكونه محالا والعالم بكون الشيء محال الوجود لا يكون مريدا له بالاتفاق
فثبت أن الله تعالى لا يريد الإيمان من الكافر
وتمام الأسئلة والأجوبة على هذا الوجه سيأتي في مسألة تكليف ما لا يطاق إن شاء الله تعالى
الثاني
هو أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على وجود الداعي والداعي مخلوق لله تعالى دفعا للتسلسل وعند حصول الداعي يجب وقوع الفعل وإلا لزم وقوع الممكن لا عن مرجح أو افتقاره إلى داعية أخرى وإلا لزم التسلسل إذا كانت الداعية مخلوقة لله تعالى وعند وجود الداعي يجب حصول الفعل فالله تعالى خلق في الكافر ما يوجب الكفر فلو أراد في هذه الحالة وجود الإيمان لزم كونه مريدا للضدين وذلك باطل بالاتفاق بيننا وبين خصومنا
فثبت بهذين الوجهين أن الله تعالى ما أراد الإيمان من الكافر
وأما أنه تعالى أمر الكافر بالإيمان فذلك مجمع عليه بين المسلمين
وإذا ظهرت المقدمتان ثبت أنه وجد الأمر بدون الإرادة وإذا ثبت ذلك ثبت أن حقيقة الأمر مغايرة لحقيقة الإرادة وغير مشروطة بها
فإن قيل ما المراد من قولك أمر الكافر بالإيمان
إن أردت به أنه أنزل لفظا يدل على كونه مريدا لعقابه في الآخرة إذا لم يصدر منه الإيمان فهذا مسلم لكن معناه نفس إرادة العقاب لا غير فلا يحصل مطلوبكم من أنه أمر بما لم يرد
وإن عنيت شيئا آخر فاذكره
سلمنا ذلك لكن لا نسلم أنه ما أراد الإيمان ولا نسلم أن إيمانه محال وسيأتي تقرير هذا المقام في مسألة تكليف ما لا يطاق
سلمناه لكن لا نسلم ان المحال غير مراد
بيانه هو أن الإرادة من جنس الطلب وإذا
جوزت طلب المحال مع العلم بكونه محالا فلم لا تجوز إرادته مع العلم بكونه محالا
والجواب
قوله الأمر بالشيء عبارة عن الإخبار عن إرادة عقاب تاركهقلت لو كان كذلك لتطرق التصديق والتكذيب إلى قوله آمنوا لأن الخبر من شأنه قبول ذلك ولأن سقوط العقاب جائز أما عندنا فبالعفو وأما عندهم ففي الصغائر قبل التوبة وفي الكبائر بعدها ولو تحقق الخبر عن وقوع العقاب لما جاز ذلك
قوله لم قلت إن إرادة المحال ممتنعة
قلنا هذا متفق عليه بيننا وبينكم
وأيضا فلأن الإرادة صفة من شأنها ترجيح أحد طرفي الجائز على الآخر وذلك في المحال محال والعلم به ضروري
وثانيها
أن الرجل قد يقول لغيره إني أريد منك هذا الفعل لكنني لا آمرك به ولو كان الأمر هو الإرادة لكان قوله أريد منك الفعل ولا آمرك به جاريا مجرى أن يقال أريد منك الفعل ولا أريده منك وقوله آمرك بهذا الفعل ولا أمرك به ومعلوم أن ذلك صريح التناقض دون الأولوثالثها
أن الحكيم قد يأمر عبده بشيء في الشاهد ولا يريد منه أن يأتي بالمأمور به لإظهار تمرده وسوء أدبه
فإن قلت ذلك ليس بأمر وإنما تصور بصورته
قلت التجربة إنما تحصل بالأمر فدل على أنه أمر
ورابعها
أنه سيظهر إن شاء الله تعالى في باب النسخ أنه يجوز نسخ ما وجب من الفعل قبل مضي مدة الامتثال فلو كان الأمر والنهي عبارتين عن الإرادة والكراهة لزم أن يكون الله تعالى مريدا كارها للفعل الواحد في الوقت الواحد من الوجه الواحد وذلك باطل بالاتفاقواحتج الخصم بوجهين
الأول
أن صيغة إفعل موضوعة لطلب الفعل وهذا الطلبإما الإرادة أو غيرها والثاني باطل لأن الطلب الذي يغاير الأرادة لو صح القول به لكان أمرا خفيا لا يطلع عليه إلا الأذكياء لكن العقلاء من أهل اللغة وضعوا هذه اللفظة للطلب الذي يعرفه كل واحد وما ذاك إلا الإرادة فعلمنا أن هذه الصيغة موضوعة للإرادة
الثاني
أن أرادة المأمور به لو لم تكن معتبرة في الأمر لصح الأمر بالماضي والواجب والممتنع قياسا على الخبر فإن إرادة المخبر عنه لما لم تكن معتبرة في الخبر صح تعلق الخبر بكل هذه الأشياءوالجواب عن الأول
لا نسلم أن الطلب النفساني الذي يغاير الإرادة غير معلوم للعقلاء فإنهم قد يأمرون بالشيء ولا يريدونه كالسيد الذي يأمر عبده بشيء ولا يريده ليمهد عذره عند السلطانوعن الثاني أنه لا بد من الجامع وعلى أن القائل بتكليف ما لا يطاق يجوزه والله أعلم
المسألة الثانية
أن هذا الطلب معنى يقتضي ترجيح جانب الفعل على جانب الترك أو جانب الترك على جانب الفعلوعلى التقديرين فالترجيح قد يكون مانعا من الطرف الآخر كما في الوجوب والحظر وقد لا يكون كما في الندب والكراهة
والتفاوت بين أصل الترجيح وبين الترجيح المانع من النقيض تفاوت بالعموم والخصوص
وأيضا
فهنا لفظ دال على أصل الترجيح ولفظ دال على الترجيح المانع من النقيضوعلى التقديرين فالمعتبر إما اللفظ الدال عليه كيف كان اللفظ وإما اللفظة العربية
فها هنا أقسام ستة
أحدها أصل الترجيح وثانيها الترجيح المانع من النقيض وثالثها ورابعها مطلق اللفظ الدال على الأول أو الثاني وخامسها وسادسها اللفظة العربية الدالة على الأول أو الثاني
ثم أنت بالخيار في إطلاق لفظ الأمر على أيها شئت أو عليها بأسرها أو على طائفة منها بحسب الاشتراك
فهذا حظ البحث العقلي
وأما البحث اللغوي فهو أن نقول
جعل الأمر اسما للصيغة الدالة على الترجيح أولى من جعله اسما لنفس الترجيح ويدل عليه وجوه
أحدها
أن أهل اللغة قالوا الأمر من الضرب إضرب ومن النصر أنصر جعلوا نفس الصيغة أمراوثانيها
لو قال إن أمرت فلانا فعبدي حر ثم أشار بما يفهممنه مدلول هذه الصيغة فإنه لا يعتق ولو كان حقيقة الأمر ما ذكرتم لزم العتق ولا يعارض هذا الحكم بما إذا خرس وأشار فإنه يعتق لأنا نمنع هذه المسألة
وثالثها
أنا لو جعلناه حقيقة في الصيغة كان مجازا في المدلول تسمية للمدلول باسم الدليل ولو جعلناه حقيقة في المدلول كان مجازا في الدليل تسمية للدليل باسم المدلول والأول أولى لأنه يلزم من فهم الدليل فهم المدلول أما لا يلزم من فهم المدلول فهم الدليل بل فهم دليل معين
ورابعها
أن الإنسان الذي قام بقلبه ذلك المعنى ولم ينطق بشيء لا يقال إنه أمر ألبتة بشيءوإذا قيل أمر فلان بكذا تبادر الذهن إلى اللفظ دون ما في القلب وذلك يدل على أن لفظ الأمر اسم للصيغة لا للمدلول
احتج المخالف بالآية والأثر والشعر والمعقول
أما الآية فقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون
الله تعالى كذبهم في شهادتهم ومعلوم أنهم كانوا صادقين في النطق اللساني فلا بد من إثبات كلام في النفس ليكون الكذب عائدا إليه
وأما الأثر فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما فسبقني إليه أبو بكر
وأما الشعر فقول الأخطل ... إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا ...
وأما المعقول فهو إن هذه الألفاظ مفردات فلو سميت كلاما لكانت إنما سميت بذلك لكونها معرفات
للمعنى النفساني فكان يجب تسمية الكتابة والإشارة كلاما وإنه باطل
والجواب عن الأول
أن الشهادة هي الإخبار عن الشيء مع العلم به فلما لم يكونوا عالمين به فلا جرم كذبهم الله تعالى في ادعائهم كونهم شاهدينوعن الثاني
أن قوله زورت في نفسي كلاما أي خمرته كما يقال قدرت في نفسي دارا وبناء
وعن الثالث
أنا لا نسلم كون الشعر عربيا محضا ولو سلمناه فمعناه أن المقصود من الكلام ما حصل في القلبوعن الرابع
أنه قياس في اللغة فلا يقبلفرع
الآمر اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب أو اللفظ العربي الدال على مطلق الطلبوالحق هو الأول لأن الفارسي إذا طلب من عبده شيئا بلغته فإن العربي يسميه أمرا ولو حلف لا يأمر فأمر بالفارسية يحنث في يمينه
وأما أنه اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب أو لمطلق اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض
فالحق هو الثاني وذلك إنما يظهر ببيان أن الأمر للوجوب
المسألة الثالثة
دلالة الصيغة المخصوصة على ماهية الطلب يكفي في تحققها الوضع من غير حاجة إلى إرادة أخرى وهو قول الكعبي
لنا وجهان
أحدهماأن هذه الصيغة لفظة وضعت لمعنى فلا تفتقر في إفادتها لما هي موضوعة له إلى الإرادة كسائر الألفاظ مثل دلالة السبع والحمار على البهيمة المخصوصة فإنه لا حاجة فيها إلى الإرادة
وثانيهما
أن الطلب النفساني أمر باطن فلا بد من الاستدلال عليه بأمر ظاهر والإرادة أمر باظن مفتقرة إلى المعرف كافتقار الطلب إليه فلو توقفت دلالة الصيغة على الطلب على تلك الإرادة لما أمكن الاستدلال بالصيغة على ذلك الطلب ألبتةاحتج المخالف بأنا نميز بين ما إذا كانت الصيغة طلبا وبين ما إذا كانت تهديدا ولا مميز إلا الإرادة
والجواب
أنها حقيقة في الطلب مجاز في التهديدفكما أن الأصل في كل الألفاظ إجراؤها على حقائقها إلا عند قيام دلالة صارفة فكذا ها هنا
المسألة الرابعة
ذهب أبو علي وأبو هاشم إلى أن إراردة المأمور به تؤثر في صيرورة صيغة إفعل أمراوهذا خطأ من وجهين
الأول
أن الآمرية لو كانت صفة للصيغة لكانت إما أن تكون حاصلة لمجموع الحروف وهو محال لأنه لا وجود لذلك المجموعوإما لأحادها فيلزم أن يكون كل واحد من الحروف التي ائتلفت صيغة منها أمرا على الاستقلال وهو محال
الثاني
إن صيغة إفعل دالة بالوضع على معنى وذلك المعنى هو أرادة المأمور فإذا كانت الإرادة نفس المدلول وجب أن لا تفيد الصيغة الدالة عليها صفة قياسا على سائر المسميات والأسماء
المسألة الخامسة
قال جمهور المعتزلة الآمر يجب أن يكون أعلى رتبة من المأمور حتى يسمى الطلب أمراوقال أبو الحسين البصري المعتبر هو الاستعلاء لا العلو وقال أصحابنا لا يعتبر العلو ولا الاستعلاء
لنا
قوله تعالى حكاية عن فوعون أنه قال لقومه ماذا تأمرون مع أنه كان أعلى رتبة منهم
وقال عمرو بن العاص لمعاوية ... أمرتك أمرا حازما فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
وقال دريد بن الصمة لنظرائه ولمن هم فوقه ... أمرتهم أمري بمنعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد حتى ضحى الغد
وقال حباب بن المنذر يخاطب يزيد بن المهلب أمير خراسان والعراق ... أمرتك أمرا حازما فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما ...
فهذه الوجوه دالة على أن العلو غير معتبر
وأما أن الاستعلاء غير معتبر فلأنهم يقولون فلان أمر فلانا على وجه الرفق واللين
نعم إذا بالغ في التواضع يمتنع إطلاق الاسم عرفا وإن ثبت ذلك لغة
واحتج المخالف على أن العلو معتبر بأنه يستقبح في العرف أن يقول القائل أمرت الأمير أو نهيته ولا يستقبحون أن يقال سألته أو طلبت منه ولولا أن الرتبة معتبرة وإلا لما كان كذلك
وأما أبو الحسين فقال اعتبار الاستعلاء أولى من اعتبار العلو لأن من قال لغيره إفعل على سبيل التضرع إليه لا يقال إنه أمره وإن كان أعلى رتبة من المقول إليه
ومن قال لغيره إفعل على سبيل الاستعلاء لا على سبيل التذلل يقال إنه أمره وإن كان المقول له أعلى رتبة منه ولهذا يصفون من هذا سبيله بالجهل والحمق من حيث أمر من هو أعلى رتبة منه
واعلم أن مدار هذا الكلام على صحة الاستعلاء وأصحابنا يمنعون منه والله أعلم
المسألة السادسة
لفظ الأمر قد يقام مقام الخبر وبالعكسأما أن الأمر يقام مقام الخبر فكما في قوله عليه الصلاة و السلام إذا لم تستح فاصنع ما شئت معناه صنعت ما شئت
وأما أن الخبر يقام مقام الأمر فكما في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
والسبب في جواز هذا المجاز أن الأمر يدل على وجود الفعل كما أن الخبر يدل عليه أيضا فبينهما مشابهة من هذا الوجه فصح المجاز
وأيضا تجوز إقامة النهي مقام الخبر وبالعكس
أما الأول فكقوله عليه الصلاة و السلام
لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر معناه لا تنكحوها إلى غاية استئمارها
وأما الثاني فكقوله صلى الله عليه و سلم لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها وكما في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون
وجه المجاز أن النهي يدل على عدم الفعل كما أن هذا الخبر يدل على عدمه فبينهما مشابهة من هذا الوجه والله أعلم
القسم الأول في المباحث اللفظية وفيه مسائل
المسألة الأولى
قال الأصوليون صيغة إفعل مستعملة في خمسى عشر وجهاالأول الإيجاب كقوله تعالى أقيموا الصلاة
الثاني الندب كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأحسنواويقرب منه التأديب كقوله عليه الصلاة و السلام
كل فما يليك فإن الأدب مندوب إليه وإن كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب
الثالث الإرشاد كقوله تعالى واستشهدوا شهيدين فاكتبوه
والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا فإنه لا ينقص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بفعليه
الرابع الإباحة كقوله تعالى
كلوا واشربوا
الخامس التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم واستفزز من استطعت منهم بصوتك
ويقرب منه الإنذار كقوله تعالى قل تمتعوا وإن كانوا قد جعلوه قسما آخرالسادس الامتنان فكلوا مما رزقكم الله
السابع الإكرام أدخلوها بسلام آمنينالثامن التسخير كقوله كونوا قردة
التاسع التعجيز فأتوا بسورة
العاشر الإهانة ذق إنك انت العزيز الكريم
الحادي عشر التسوية صبروا أو لا تصبرواالثاني عشر الدعاء رب اغفر لي
الثالث عشر التمني كقوله ... ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ...الرابع عشر الاحتقار كقوله ألقوا ما أنتم ملقون
الخامس عشر التكوين كقوله كن فيكون
إذا عرفت هذا فنقول
اتفقوا على أن صيغة إفعل ليست حقيقة في جميع هذه الوجوه لأن خصوصية التسخير والتعجيز
والتسوية غير مستفادة من مجرد هذه الصيغة بل إنما تفهم تلك من القرائن
إنما الذي وقع الخلاف فيه أمور خمسة الوجوب و الندب و الإباحة و التنزيه و التحريم
فمن الناس من جعل هذه الصيغة بين هذه الخمسة
ومنهم من جعلها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة
ومنهم من جعلها حقيقة لأقل المراتب وهو الإباحة
والحق أنها ليست حقيقة في هذه الأمور
لنا
أنا ندرك التفرقة في اللغات كلها بين قوله إفعل وبين قوله إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل حتى إذا قدرنا انتفاء القرائن كلها وقدرنا هذه الصيغة منقولة على سبيل الحكاية عن ميت أو غائب لا في فعل معين حتى يتوهم فيه قرينة دالة بل في الفعل مطلقا سبق إلى فهمنا اختلاف معاني هذه الصيغ وعلمنا قطعا أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد
كما ندرك التفرقة بين قولهم قام زيد ويقوم زيد في أن الأول للماضي والثاني للمستقبل وإن كان قد يعبر عن الماضي بالمستقبل وبالعكس لقرائن تدل عليه
فكذلك ميزوا الأمر عن النهي فقالوا الأمر أن
تقول إفعل والنهي أن تقول لا تفعل فهذا أمر معلوم بالضرورة من اللغات لا يشككنا فيه إطلاقه مع قرينة على الإباحة أو التهديد
فإن قيل تدعي الفرق بين إفعل و لا تفعل في حق من يعتقد كون اللفظ موضوعا للكل حقيقة أو في حق من لا يعتقد ذلك
الأول ممنوع والثاني مسلم
بيانه أن كل من اعتقد كون هذه اللفظة موضوعة لهذه المعاني فإنه يحصل في ذهنه الاستواء
أما من لا يعتقد ذلك فإنه لا يحصل عنده الرجحان
سلما الرجحان لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك للعرف الطارىء لا في أصل الوضع كما في الألفاظ العرفية
سلمناأن ما ذكرته يدل على قولك لكنه معارض بما يدل على نقيضه وهو أن الصيغة قد جاءت بمعنى التهديد والإباحة والأصل في الكلام الحقيقة
والجواب عن الأول أنه مكابرة فإنا نعلم عند انتفاء كل القرائن بأسرها أنه
يكون فهم الطلب من لفظ إفعل راجحا على فهم التهديد والإباحة
وعن الثاني أن الأصل عدم التغيير
وعن الثالث أنك قد عرفت أن المجاز أولى من الاشتراك ووجه المجاز أن هذه الأمور الخمسة أعني الوجوب والندب والإباحة والتنزيه والتحريم أضداد وإطلاق اسم الضد على الضد أحد وجوه المجاز والله أعلمالمسألة الثانية
الحق عندنا أن لفظة إفعل حقيقة في الترجيح المانع من النقيض وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمينوقال أبو هاشم إنه يفيد الندب
ومنهم من قال بالوقف وهم فرق ثلاث
الفرقة الأولى الذين يقولون إنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب
والندب وهو ترجيح الفعل على التركثم جاء الوجوب يمتاز عن الندب بامتناع الترك والندب يمتاز عن الوجوب بجواز الترك وليس في الصيغة إشعار بهذين القيدين
ويليق بمذهب هؤلاء أن يقولوا إنه يجب حمله على الندب لأن اللفظ يفيد رجحان الفعل على الترك وليس فيه ما يدل على المنع من الترك وقد كان جواز الترك معلوما بحكم الاستصحاب وإذا كان كذلك كان جواز الترك بحكم الاستصحاب ورجحان الفعل بدلالة اللفظ ولا معنى للندب إلا ذلك
الفرقة الثانية الذين قالوا إن صيغة إفعل موضوعة للوجوب والندب على سبيل
الاشتراك اللفظي وهو قول المرتضى من الشيعةالفرقة الثالثة الذين قالوا إنها حقيقة إما في الوجوب فقط أو في الندب فقط أو فيهما معا بالاشتراك لكنا لا ندري ما هو الحق من هذه الأقسام الثلاثة فلا جرم توقفنا في الكل وهو قول الغزالي منا
لنا وجوه
الدليل الأولالتمسك بقوله تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق بل الذم فإنه لا عذر له في الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر به هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده ما منعك من دخول الدار إذ أمرتك إذا لم يكن مستفهما ولو لم يكن الأمر دالا على الوجوب لما ذمه الله تعالى على الترك ولكان لإبليس أن يقول إنك ما ألزمتني السجود
فإن قلت لعل الأمر في تلك اللغة كان يفيد الوجوب فلم قلتم إنه في هذه اللغة للوجوب
قلنا الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر فتخصيصه بأمر خاص خلاف الظاهر
الدليل الثاني
التمسك بقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذمهم على انهم تركوا فعل ما قيل لهم افعلوه ولو كان الأمر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام كما إذا قيل لهم
الأولى أن تفعلوه ويجوز لكم تركه فإنه ليس لنا أن نذمهم على تركه
فإن قلت إنما ذمهم لا لأنهم تركوا المأمور به بل لأنهم لم يعتقدوا حقيقة الأمر
والدليل عليه قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين
وأيضا فصيغة إفعل قد تفيد الوجوب عند اقتران بعض القرائن بها فلعله تعالى إنما ذمهم لأنه كان قد وجدت قرينة دالة على الوجوب
والجواب عن الأول
أن المكذبين في قوله ويل يومئذ للمكذبين إما أن يكونوا هم الذين تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا أو غيرهم فإن كان الأول جاز أن يستحقوا الذم بترك الركوع والويل بسبب التكذيب فإن عندنا الكافر كما يستحق العقاب بترك الإيمان يستحق الذم والعقاب أيضا بترك العبادات
وإن كان الثاني لم يكن إثبات الويل لإنسان بسبب التكذيب منافيا ثبوت الذم لإنسان آخر بسبب ترك المأمور به
وعن الثاني أنه تعالى إنما ذمهم لمجرد أنهم تركوا الركوع لما قيل لهم
اركعوا فدل على أن منشأ الذم هذا القدر لا القرينة
الدليل الثالث
لو لم يكن الأمر ملزما للفعل لما كان إلزام الأمر سببا للزوم المأمور به لكنه سبب للزوم المأمور به فوجب أن يكون الأمر ملزما للفعلبيان الشرطية أن بتقدير أن لا يكون الأمر ملزما للفعل كان إلزام الأمر إلزاما لشيء وذلك الشيء لا يوجب فعل المأمور به فوجب أن لا يكون هذا القدر سببا للزوم المأمور به
وبيان أن إلزام الأمر سبب للزوم المأمور به قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
والقضاء هو الإلزام فقوله تعالى إذا قضى الله ورسوله أمرا معناه إذا
ألزم الله ورسوله أمرا فإنه لا خيرة للمؤمنين في المأمور به
ويجب ها هنا حمل لفظ الأمر على المأمور به إذ لو أجريناه على ظاهره لصار المعنى أنه لا خيرة للمؤمنين في صفة الله تعالى وذلك كلام غير مفيد
وإذا تعذر حمله على نفس الآمر وجب حمله على المأمور به فيصير التقدير أن الله تعالى إذا ألزم المكلف أمرا فإنه لا خيرة له في المأمور به
وإذا انتفت الخيرة بقي إما الحظر وإما الوجوب والحظر منتف بالإجماع فتعين الوجوب
فإن قيل القضاء هو الإلزام والأمر قد يرد بمعنى شيء فقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا أي إذا ألزم الله ورسوله
شيئا
ونحن نعترف بأن الله تعالى إذا ألزمنا شيئا فإنه يكون واجبا علينا و لكن لم قلت إنه بمجرد أن يأمرنا بالشيء فقد ألزمنا فإن ذلك عين المتنازع في
والجواب
قد بينا أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص وليس حقيقة في الشيء دفعا للاشتراك ولا ضرورة ها هنا في صرفه عن ظاهرهإذا ثبت هذا فقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا
معناه إذا ألزم الله أمرا وإلزام الأمر هو توجيهه على المكلف شاء أم أبى
وإلزام الأمر غير إلزام المأمور به فإن القاضي إذا قضى بإباحة شيء فقد ثبت إلزام الحكم ولو لم يثبت المحكوم به فكذا ها هنا إلزام الأمر عبارة عن توجيهه على المكلف والقطع بوقوع ذلك الأمر
ثم الأمر إن لم يقتض الوجوب لم يكن إلزام الأمر إلزاما للمأمور به وإن كان مقتضبا للوجوب فهو الذي قلناه
الدليل الرابع
تارك ما أمر الله أو رسوله به مخالف لذلك الأمر ومخالف ذلك الأمر مستحق للعقاب فتارك ما أمر الله أو رسوله به مستحق للعقاب ولا معنى لقولنا الأمر للوجوب إلا ذلكوإنما قلنا إن تارك ما أمر الله أو رسوله به مخالف لذلك الأمر لأن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه والمخالفة ضد الموافقة فكانت مخالفة ألأمر عبارةعن الإخلال بمقتضاه فثبت أن تارك ما أمر الله او رسوله به مخالف لذلك الأمر
وإنما قلنا إن مخالف ذلك الأمر يستحق العقاب
لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أمر مخالف هذا الأمر بالحذر عن العذاب والأمر بالحذر عن العذاب إنما يكون بعد قيام المقتضي لنزول العذاب فدل على أن مخالف أمر الله أو أمر رسوله قد وجد في حقه ما يقتضي نزول العذاب به
فإن قيل لا نسلم أن تارك المأمور به مخالف للأمر
قوله موافقة الأمر عبارةعن الإتيان بمقتضاه
قلنا لا نسلم أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه وما الدليل عليه
ثم إنا نفسر موافقة الأمر بتفسيرين آخرين
أحدهما أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بما يقتضيه الأمر على الوجه الذي يقتضيه الأمر فإن الأمر لو اقتضاه على سبيل الندب وأنت تأتي به على سبيل الوجوب كان هذا مخالفة للأمر
وثانيهما أن موافقة الأمر عبارة عن الاعتراف بكون ذلك الأمر حقا واجب القبول ومخالفته عبارة عن إنكار كونه حقا وجاب القبول
سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أن مخالفة الأمر عبارة عن ترك مقتضاه لكن ها هنا ما يدل على أنه ليس كذلك
فإنه لو كان ترك المأمور به عبارة عن مخالفة الأمر
لكان ترك المندوب مخالفة لأمر الله تعالى وذلك باطل لأن وصل الإنسان بأنه مخالف لأمر لله تعالى اسم ذم فلا يجوز إطلاقه على تارك المندوب
سلمنا أن تارك المندوب مخالف للأمر فلم قلت إن مخالف الأمر مستحق للعقاب
أما قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية
قلنا لا نسلم أن هذه الآية دالة على أمر من يكون مخالفا للأمر بالحذر بل هي دالة على الأمر بالحذر عن مخالف الأمر فلم لايجوز أن تكون كذلك
سلمنا ذلك ولكنها دالة على أن المخالف عن الأمر يلزمه الحذر
فلم قلت إن مخالف الأمر يلزمه الحذر
فإن قلت لفظة عن صلة زائدة
قلت الأصل في الكلام الاعتبار لا سيما في كلام الله تعالى فلا يكون زائدا
سلمنا دلالة الآية على أن مخالف الأمر مأمور بالحذر عن العذاب فلم قلت يجب عليه الحذر عن العذاب
أقصى ما في الباب أنه ورد الأمر به لكن لم قلت إن الأمر للوجوب فإن ذلك أول المسألة
فإن قلت هب أنه لا يدل على وجوب الحذر لكن لا بد وأن يدل على حسن الحذر وحسن الحذر إنما يكون بعد قيام المقتضي لنزول العذاب
قلت لا نسلم أن حسن الحذر مشروط بقيام ما يقتضي نزول العذاب بل الحذر يحسن عند احتمال نزول العذاب
وعندنا مجرد الاحتمال قائم لأن هذه المسألة اجتهادية لا قطعية سلمنا دلالة الآية على قيام ما يقتضي نزول العذاب لكن لا في كل أمر بل في أمر واحد لأن قوله عن أمره لا يفيد إلا أمرا واحدا
وعندنا أن أمرا واحدا يفيدالوجوب فلم قلت إن كل أمر كذلك
سلمنا أن كل أمر كذلك لكن الضمير في قوله عن أمره يحتمل عوده إلى الله تعالى وعوده إلى رسوله فالآية لا تدل على أن الأمر للوجوب إلا في حق أحدهما فلم قلت إنه في حق الاخر كذلك
والجواب
قوله لم قلت إن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه قلنا الدليل عليه أن العبد إذا امتثل أمر السيد حسن أن يقال هذا العبد موافق للسيد و يجري على وفق أمره ولو لم يمتثل أمره يقال إنه ما وافقه بل خالفه وحسن هذا الإطلاق من أهل اللغة معلوم بالضرورةفثبت أن موافقةالأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه
قوله الموافقة عبارة عن الإتيان بما يقتضيه الأمر على الوجه الذي يقتضيه الأمر
قلنا لما سلمتم أن موافقة الأمر لا تحصل إلا عند الإتيان بمقتضى الأمر فنقول لا شك أن مقتضى الأمر هو الفعل لأن قوله إفعل لا يدل إلا على اقتضاء الفعل فإذا لم يوجد الفعل لم يوجد مقتضى الأمر وإذا لم يوجد مقتضى الأمر
لم توجد الموافقة وإذا لم توجد موافقة الأمر حصلت مخالفته لأنه ليس بين الموافقة والمخالفة واسطة
قوله الموافقة عبارة عن اعتقاد كون ذلك الأمر حقا واجب القبول
قلنا هذا لا يكون موافقة للأمر بل موافقة للدليل الدال على أن ذلك الأمر حق فإن موافقة الشيء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه فإذا دل الدليل على حقية الأمر كان الاعتراف بحقيته مستلزما تقرير مقتضى ذلك الدليل
أما الأمر فلما اقتضى دخول ذلك الفعل في الوجود كانت موافقته عبارة عما تقرر دخوله في الوجود وإدخاله
في الوجود يقرر دخوله في الوجود فكانت موافقة الأمر عبارة عن فعل مقتضاه
قوله لو كانت مخالفة الأمر عبارة عن ترك المأمور به لكنا إذا تركنا المندوب فقد خالفنا الأمر
قلنا هذا الإلزام إنما يصح لو كان المندوب مأمورا به وإنما يكون المندوب مأمورا به لو ثبت أن الأمر ليس للوجوب وهذا عين المتنازع فيه
قوله لم لا يجوز أن يكون قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمرا بالحذر عن المخالف لا أمرا للمخالف بالحذر
قلنا الدليل عليه وجوه
أحدها
أن النحويين اتفقوا على أن تعلق الفعل بفاعله أقوى من تعلقه بمفعوله فلو جعلناه أمرا للمخالف بالحذر لكنا قد أسندنا الفعل إلى الفاعل ولو جعلناه أمرا بالحذر عن المخالف لكنا قد أسندنا الفعل إلى المفعول فيكون الأول أولىوثانيها
لو جعلناه أمرا بالحذر عن المخالف لم يتعين المأمور به فإن قلت المأمور به هو ما تقدم وهو قوله الذين يتسللون منكم لواذاقلت المتسللون منهم لواذا هم الذين خالفوا فلو أمروا بالحذر عن المخالف لكانوا قد أمروا بالحذر عن أنفسهم وهو لا يحوز
وثالثها
إنا لو جعلناه أمرا بالحذر عن المخالف لصار التقدير فليحذر المتسللون لواذا عن الذين يخالفون أمره وحينئذ يبقى قوله أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم ضائعا لأن الحذر ليس فعلا يتعدى لى مفعولين
قوله الآية دالة على وجوب الحذر عمن خالف عن الأمر لا عمن خالف الأمر
قلنا قال النحاة كلمة عن للبعد و المجاوزة يقال جلس عن يمينه أي متراخيا عن بدنه في المكان الذي بحيال يمينه فلما كانت مخالفة أمر الله تعالى بعدا عن أمر الله تعالى لا جرم ذكره بلفظ عن
قوله لم قلت إن قوله تعالى فليحذر يدل على وجوب الحذر عن العذاب
قلنا لا ندعي وجوب الحذر عن العقاب ولكنه لا أقل من أن يدل على جواز الحذر وجواز الحذر عن الشيء مشروط بوجود ما يقتضي وقوعه لأنه لو لم يوجد المقتضي لوقوعه لكان الحذر عنه حذرا عما لم يوجد
ولم يوجد المقتضى لوقوعه وذلك سفه وعبث فلا يجوز ورود الأمر به
قوله دلت الآية على أن مخالف أمر الله يستحق العقاب أو على أن مخالف كل أمر يستحق العقاب
قلنا دلت على الثاني لوجوه
الأول
أنه يجوز استثنار كل واحد من أنواع المخالفات نحو أن يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا مخالفة الأمر الفلاني والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه وذلك يفيد العموم
الثاني
أنه تعالى رتب استحقاق العقاب على مخالفة الأمر وترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعليةالثالث
أنه لما ثبت أن مخالف الأمر في بعض الصور يستحق العقاب فنقول إنما استحق العقاب لأن مخالفة الأمر تقتضي عدم المبالاة بالأمر وذلك يناسبه الزجر وهذا المعنى قائم في كل المخالفات فوجب ترتب العقاب على الكلقوله هب أن أمر الله أو أمر رسوله للوجوب فلم قلتم إن أمر الآخر كذلك
قلنا لأنه لا قائل بالفرق
الدليل الخامس
تارك المأمور به عاص وكل عاص يستحق العقاب فتارك المأمور به يستحق العقاب ولا معنى للوجوب إلا ذلكبيان الأول قوله تعالى ولا أعصي لك أمرا أفعصيت أمري لا يعصون الله ما أمرهم
بيان الثاني قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا
خالدا فيها
فإن قيل لا نسلم أن تارك المأمور به عاص وبيانه من وجوه
ألأول
قوله تعالى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فلو كان العصيان عبارة عن ترك المأمور به لكان معنى قوله لا يعصون الله ما أمرهم أنهم يفعلون ما يؤمرون به فكان قوله ويفعلون ما يؤمرون تكرارا
الثاني
أجمع المسلمون على أن الأمر قد يكون أمر إيجاب وقد يكون أمر استحباب وتارك المندوب غير عاص وإلا لاستحق النار لما ذكرتموه فعلمنا أن المعصية ليست عبارة عن ترك المأمور بهسلمنا أن المعصية عبارة عن ترك ترك المأمور به لكن إذا كان الأمر أمر إيجاب أو مطلقا
الأول مسلم والثاني ممنوع
بيانه أن قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم
حكاية حال فيكفي في تحقيقها تنزيلها على صورة واحدة فلعل ذلك الأمر كان أمر إيجاب فلا جرم كان تركه معصية
سلمنا أن تارك المأمور به عاص مطلقا فلم قلت إن العاصي يستحق العقاب والآية المذكورة مختصة بالكفار لقرينة الخلود
والجواب قد بينا أن تارك المأمور به عاص
قوله لو كان كذلك لكان قوله ويفعلون ما يؤمرون تكرارا
قلنا لا نسلم بل معنى الآية والله أعلم لا يعصون الله ما أمرهم به في الماضي ويفعلون ما يؤمرون به في المستقبل
قوله الأمر قد يكون أمر استحباب
قلنا لا نسلم كون المستحب مأمورا به حقيقة بل مجازا لأن الاستحباب لازم للوجوب وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز
فإن قلت ليس الحكم بكون هذه الصيغة للوجوب محافظة على عموم قوله ومن يعص الله ورسوله أولى من القول بأن المستحب مامور به محافظة على صيغ الأوامر الواردة في المندوبات
قلت بل ما ذكرناه أولى للاحتياط ولأنا لو حملناه
على الوجوب لكان أصل الترجيح داخلا فيه فيكون لازما للمسمى فيجوز جعله مجازا في أصل الترجيح
أما لو جعلناه لأصل الترجيح لم يكن الوجوب لازما له فلا يمكن جعله مجازا عن الوجوب فكان الأول أولى
قوله هذه الآية حكاية حال
قلنا الله تعالى رتب اسم المعصية على مخالفة الأمر فيكون المتقضي لاستحقاق هذا الاسم هذا المعنى فيعم الاسم لعموم ما يقتضي استحقاقه
قوله الآية مختصة بالكفار بقرينة الخلود
قلنا الخلود هو المكث الطويل لا الدائم والله أعلم
واعلم أن هذا الدليل قد يقرر على وجه آخر فيقال
إنما قلنا إن تارك المأمور به عاص لأن بناء لفظة العصيان على الامتناع ولذلك سميت العصا عصا لأنه يمتنع بها وتسمى الجماعة عصا يقال شققت عصا المسلمين أي جماعتهم لأنها يمتنع بكثرتها
وهذا كلام مستعص على الحفظ أي ممتنع وهذا الحطب مستعص على الكسر