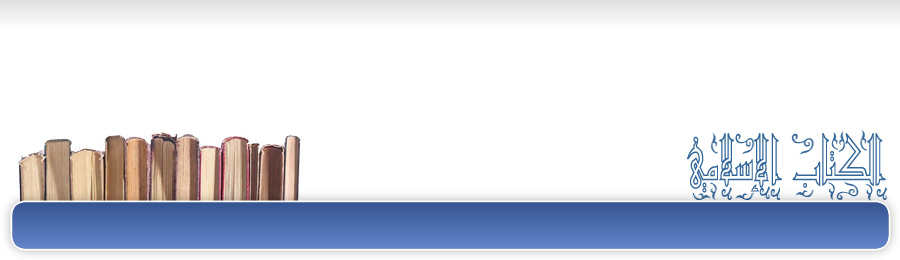كتاب : الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول
للبيضاوي
المؤلف : علي بن عبد الكافي السبكي
كتاب الإبهاج في شرح المنهاج
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم قال الشيخ الإمام العالم العلامة القدوة المحقق الحافظ شيخ الإسلام بقية العلماء الأعلام قدوة الأئمة آ آخر المجتهدين حجة الله على العالمين سيدنا ومولانا قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن علي بن تمام بن سوار بن سوار بن مسوار الأنصاري الخزرجي الشافعي نضر الله وجهه قاضي القضاة بالشام المحروس
قال رحمه الله تعالى الحمد لله الذي أسس بنيان دينه على أثبت قواعد وأعلى أعلام ملته فخضعت لها أعناق كل جاحد وأحكم أصول شريعته فأعيا تفريعها كل معاند ورفع قدر علمائها فعد كل واحد منهم بألف كما عد ألف من غيرهم بواحد أحمده على نعمه التي عمت كل صادر ووارد واعترف بالعجز عن شكره ولا يبلغ معشار عشره حمد كل حامد وأستغفره استغفار عبد في بحر الذنوب راكد لا يجد ملجأ من الله إلا إليه قد أحاطت به الشدائد وقعد له عدوه بالمراصد وسولت له نفسه بالمكايد وغلب عليه هواه الفاسد ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنك أنت الإله الواحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا أنا له في صميم القلب واجد وعليه في الدنيا والآخرة شاهد وأصفه بما وصف به نفسه من صفات الكمال والمحامد وأنزهه عن كل ما لا يليق بحاله وأقدس له عن وضر التشبيه والتعطيل ما تكنه القلوب من العقائد و أستودعه ذلك ليوم لا يجزى فيه ولد ولا والد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قدره على جميع الخلائق صاعد وشرفه بين البرية ناهد المصطفى من خير القبائل الأماجد والمجتبى من خير البطون الأقارب والأباعد المبرأ في نسبه
وذاته عن كل شين يتعلق به حاسد المقدم على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين في جميع المشاهد والمبعوث إلى كل إنسي وجني والمنقذ لهم من ربقة الشيطان المارد الهادي إلى سبيل الرشاد ولولاه لم يكن أحد منا براشد
صلى الله عليه و سلم ما سجد لله ساجد ودام في الجنان خالد ورضي الله على أصحابه الذين كل منهم في الله جاهد مجاهد وحامي حوزة الدين من كل مارق في الدين مجالد الذين قاموا بجلالة نبيه في جميع المعاهد وشيدوا أركان دينه وحفظوا شرائعه في جميع المصادر والموارد وقاموا بأعباء الملة الحنيفية وذبوا عنها كل زائد وحموا حماها عن الشبهات ووقفوا عند حدودها تحصيلا للمصالح ودرأ للمفاسد رضي الله عنهم أجمعين وعن جميع علماء المسلمين الذين خلفوا الصحابة والتابعين في تمهيد القواعد واستخراج الفوائد وضبط الأصول الشوارد وتبيين الأدلة والمقاصد والتوسع في علوم القرآن التي يتيه في بحارها كل عالم ناقد ومعرفة السنة ولا يخطئ بعضها إلا من هو أسهد الليل مكايد
وقد تجرد لذلك في المائة الثانية جماعة من العلماء ما منهم إلا من جاهد وجاهد وكد ودأب ونصب واجتهد والله لسعيه شاهد وكان من أعظمهم منة على من بعده من طلاب الفوائد الإمام الشافعي رضي الله عنه فإن له أجمل العوائد لجمعه بين الحديث والفقه وكان غيره يقتصر منهما على واحد ولبناية كلامه على أصول هو أول من صنفها لما سأله ابن مهدي فصنف له الرسالة وكم فيها من الفوائد فهو أول من صنف في أصول الفقه لا يمتري في ذلك إلا معاند
فائدة علم الأصول
وإن علم أصول الفقه وهو من أعظم العلوم ثلاثة أصناف عقلية محضة كالحساب والهندسة والنجوم والطب ولغوية كعلم اللغة والنحو والتصريف والعروض والقوافي والبيان وهي علوم القرآن والسنة وتوابعهماولا ريب في أن الشريعة أشرف الأصناف الثلاثة في الوسائل والمقاصد وأشرف العلوم الشرعية بعد الاعتقاد الصحيح وأنفعها معرفة الأحكام التي
تجب للمعبود على العابد ومعرفة ذلك بالتقليد ونقل الفروع المجردة تستفرغ جمام الذهن ولا ينشرح الصدر له لعدم أخذه بالدليل وأين سامع الخبر من المشاهد وأين أجر من يأتي بالعبادة لفتوى إمامه أنها واجبة أو سنة من الذي يأتي بها وقد ثلج صدره عن الله ورسوله بأن ذلك دينه تالله إن أجر هذا لزائد وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد ولا يكمل فيه إلا الواحد بعد الواحد وكل العلماء في حضيض عنه إلا من نغلغل بأصل الفقه وكرع من مناهله الصافية بكل الموارد وسبح في بحره ودرى من الإله وبات يعل به وطرفه ساهد وإني لم أزل منذ نشأت محبا في هذا العلم مولعا بالبحث فيه مع كل زائد
وقد أكثر الناس من التصنيف فيه فكم من تصنيف فيه مبسوط ومختصر وناقص وزائد ومن أحسن مختصراته كتاب المنهاج في الوصول إلى العلم الأصول الذي صنفه القاضي الفاضل ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي رحمه الله فلقد أحسن فيه المعاقد وقد قرئ على مرات كثيرة من جماعات حتى سمحت أقرأه من كثرة الموارد وانتشرت طلبته فلم أقتنع من واحد وفي هذا الوقت شرع في الاشتغال به ولدي أبو حامد أعطاه الله من خير الدنيا والآخرة ما هو قاصد وزاده مما ليس في حسابه كل خير إنه الكريم الماجد فأحببت أن أضع له شرحا لينتفع هو وغيره به إن شاء الله
وعسى دعوة من أخ في الله تنفعني وأنا في القبر راقد وسميته الإبهاج في شرح المنهاج وأخذت هذا الاسم من قول ذي الرمة ... تزداد للعين إبهاجا إذا سفرت ... ومخرج العبن فيها يلتفت ...
وذلك من قصيدته التي قرأتها على أبي محمد الحسن عبد الكريم سبط زيادة في
سنة سبع وسبعمائة عن عيسى بن عبد العزيز بن عيسى قال أخبرنا السلفي قال أخبرنا جعفر السراج قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال قرأت على أبي الحسن علي بن عيسى الرماني قال سمعت ديوان ذي الرمة على أبي بكر دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة واسمه غيلان ابن عقبة العدوي
فإن قلت قد عظمت أصول الفقه وهل هو إلا نبذ جمعت من علوم متفرقة نبذة من النحو وهي الكلام في معاني الحروف التي يحتاج إليها الفقيه والكلام في الاستفتاء وما أشبه ذلك ونبذة من علم الكلام وهي الكلام في الحسن والقبيح والكلام في الحكم الشرعي وأقسامه وبعض الكلام في النسخ وأفعاله ونحو ذلك ونبذة من اللغة وهي الكلام في معنى الأمر والنهي وصيغ العموم والمجمل والمبين والمطلق والمقيد وما أشبه ذلك ونبذة من علم الحديث وهي الكلا في الأخبار والعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه في الإحاطة بها فلم يبق من أصول الفقه إلا الكلام في الإجماع وهو من أصول الدين أيضا وبعض الكلام في القياس والتعارض مما يستقل به الفقيه فصارت فائدة الأصول بالذات قليلة جدا بحيث لو جرد الذي ينفرد به ما كان إلا شيئا يسيرا
قلت ليس كذلك فإن الإصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون فإن كلام العرب متسع جدا والنظر فيه متشعب فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصول واستقراء زائد على استقراء اللغوي مثاله ودلالة صيغة أفعل على الوجوب ولا تفعل على التحريم وكون كل وإخوتها للعموم يوما أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة لو فتشت كتب اللغة لم تجد فيها شفاء في ذلك ولا تعرضا لما ذكره الأصوليون وكذلك كتب النحو لو طلبت معنى الاستثناء وأن الإخراج هل هو قبل الحكم أبو بعد الحكم ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون وأخذوها باستقراء خاص من كلام العرب وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو فهذا ونحوه مما تكفل به أصول الفقه ولا ينكر أن له استمداد من تلك العلوم ولكن تلك الأشياء التي استمدها
منها لم تذكر فيه بالذات بل بالعرض والمذكور فيه بالذات ما أشرنا إليه مما لا يوجد إلا فيه ولا يصل إلى فهمها إلى من يلتف به
فإن قلت قد كانت العلماء في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من أكابر المجتهدين ولم يكن هذا العلم حتى جاء الشافعي وصنف فيه فكيف تجعله شرطا في الاجتهاد
قلت الصحابة ومن بعدهم كانوا عارفين به بطباعهم كما كانوا عارفين النحو بطباعهم قبل مجئ الخليل وسيبويه فكانت ألسنتهم قويمة وأذهانهم مستقيمة وفهمهم لظاهر كلام العرب ودقيقه عتيد لأنهم أهله الذي يؤخذ عنهم وأما بعدهم فقد فسرت الألسن وتغيرت الفهوم فيحتاج إليه كما يحتاج إلى النحو
شروط المجتهد
واعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياءأحدها التأليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقه وما يحتاج إليه من العلوم العقلية في صيانة الذهن عن الخطأ بحيث تصير هذه العلوم ملكة الشخص فإذ ذاك يثق بفهمه لدلالات الألفاظ من حيث هي هي وتحريره تصحيح الأدلة من فاسدها والذي نشير إليه من العربية وأصول الفقه كانت الصحابة أعلم به منا من غير تعلم وغاية المتعلم منا أن يصل إلى بعض فهمهم وقد يخطئ وقد يصيب
الثاني الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق
الثالث أن يكون له منة الممارسة والتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل وإن لم يصرح به كما أن من عاشر ملكا ومارس أحواله وخبر أموره إذا سئل عن رأيه في القضية الفلانية يغلب على ظنه ما يقوله فيها وإن لم يصرح له به
لكن بمعرفته بأخلاقه وما يناسبها من تلك القضية فإذا وصل الشخص إلى هذه الرتبة وحصل على الأشياء الثلاثة فقد حاز رتبة الكاملين في الاجتهاد ولا يشترط العلم بأحوال الرواة من حيث هو فإن الصحابة كانوا مجتهدين ولم يحتاجوا إلى ذلك وإنما الذين بعدهم يحتاجون إلى ذلك في إيقاع الاجتهاد لا في حصول الصفة لهم وذاك العلم بمواقع الإجماع والاختلاف وكان محل الكلام على هذا في أواخر الكتاب ولكنا تعجلناه هنا
ومن المعلوم أن الصحابة كانوا أكمل الناس في هذه الأشياء الثلاثة أما الأول فبطباعهم وأما الثاني والثالث فلمشاهدتهم الوحي ومعرفتهم بأحوال النبي صلى الله عليه و سلم
ولما كان الفقه مستندا إلى الكتاب والسنة ويحتاج الفقيه في أخذه منهما إلى قواعد جمعت تلك القواعد في علم وسميته أصول الفقه وهي تسمية صحيحة مطابقة لتوقف الفقه عليها وتلك القواعد منها ما لا يعرف إلا من الشرع ومنها ما يعرف من اللغة بزيادة على ما تصدى له النحاة واللغويون فالذي لا يعرف إلا من الشرع إثبات كون الخبر الواحد حجة وكون الإجماع حجة والقياس حجة وكثير من المسائل التي تذكر فيه والذي يعرف من اللغة ما يذكر فيه من دلالات الألفاظ اللغوية وما فيه من علم الكلام ونحوه فاقتضاه انجرار الكلام إليه وتوقف فهم بعض مسائل هذا العلم عليه
وهأنا أبتدئ في شرح هذا الكتاب مستعينا بالله تعالى وذلك في يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وسبعمائة وإلى الله أتضرع وأنا أسأل أن ينفع به بمنه وكرمه إنه قريب مجيب
شرح ديباجة الكتاب
تقدس من تمجد بالعظمة والجلال تقدس أي تطهر ومن أسمائه تعالى التي نطق بها القرآن القدوس وفيه لغتان ضم القاف وهي أشهر وكان س يقول بفتحها وأصل الكلمة من القدس بضم الدال وبسكونها وهو الطهارة سمي جبريل روح القدس لطهارته في تبليغ الوحي إلى الرسل عليهم السلام والأرض المقدسة المطهرة وبيت المقدس بيت الطهارة من الذنوب لتطهيره من الكفار بالمسلمين وقال تعالى ونقدس لك أي نقدسك إن جعلت اللام زائدة أو نقدس أنفسنا لك إن لم ترض زيادتها ومعنى تقديس الله تنزيهه من كل ما لا يليق بكماله سبحانه وتعالى فنزهه عن كل وصف يدركه حس أو يصوره خيال وهم أو يختلج به ضميره وننزهه عن كل ما نسبه إليه المبطلون من الشركاء والأنداد والصحابة والأولاد وعن كل محال نسبه إليه أهل الضلال مما يشير إلى نقص أو يومئ إلى عيبولولا ما وقع فيه أهل الكفر والضلال من ذلك لكان الأدب بنا تنزيه عن أن ننطق بنفي ذلك عنه لأن نفي الوجود يكاد يوهم بإمكان الوجود وتطرق العيب والنقص إليه محال لا يخطر بالبال تصوره فضلا عن كونه ينفيه
ويقدره وقولنا تنزيهه عن كل ما لا يليق بكماله عبارة محررة من قول من يقول بأوصاف الكمال فإن أكثر ما يتصور الناس من أوصاف الكمال ما هو كمال لأنفسهم كعلمهم وسمعهم وبصرهم والله تعالى منزه عنها فإن صفاته تعالى لا تشبه صفات البشر وعلمه وسمعه وبصره مباين لسمعهم وبصرهم وعلمهم فتنزيه كثير من الجهال يحتاج إلى تنزيه ومجامع التقديس أن تقدسه عن الشركاء والأضداد والنظير والولد وإحاطة الأبصار والحاجة إلى غيره وغير ذلك مما يستحيل عليه وأكثر الناس يعتقدون أن معنى القدوس الطاهر ولا شك أنه يدل على ذلك ولكنه ليس كل معناه فإن بناء طاهر لازم وقدوس مأخوذ من فعل متعد فمعناه مطهر بكسر الهاء أي أنه تعالى مقدس لنفسه بإخباره عنها التوحيد والإجلال والإكرام واستحالة النقائض عليه وعجز الأوهام عنه وخالق الأدلة على ذلك ومقدس لخلقه عن اعتقادهم فيه ما لا يليق بذاته والأول صفة ذات والثاني والثالث صفتا فعل وعن ابن عباس وقتادة القدس الذي منه البركات
إذا عرفت ذلك فقوله تقدس لا يجوز أن يكون مطاوعا لقدس فإن المطاوع شرطه التأثر مثل كسرته فتكسر وذلك مفقود هنا والتقديس هنا مثل التصديق في أن المراد منه الإخبار عن الصدق فلا يأتي منه مضارع لكن يصح استعمال تقدس لموافقة المجرد وقال الراجز الحمد لله العلي القادس ومن جملة معاني تفعل أن يوافق المجرد وإن لم ينطق بالمجرد ههنا في الفعل وقد قال القرافي في قوله تبارك وتعالى أن معناه تقدس وللمصنف في القرآن أسوة في استعماله تقدس وكذلك السهيلي وهو من المتقنين في العلم وقع في كلامه تقدس سبحانه عن مضاهاة الأجسام وقدوس مثل سبوح كان س يفتح أولهما والمشهور الضم فيها والتسبيح التنزيه ولم يرد السبوح في القرآن ولا في حديث أبي هريرة ولكن جاء التسبيح واختلف العلماء هل كونه سبوحا قدوسا يرجع إلى معنى خاص يسمى قدسا وسبحة أو وضعه بذلك يرجع إلى نفي محض وتنزيه عن النقائض ومعنى ذلك أنه هل هو صفة ثبوتية أو سلبية
وقوله تمجد الكلام فيه كالكلام في تقدس وهو مأخوذ من اسم المجيد وقد نطق به القرآن والسنة وأجمعت الأمة عليه والمجد معناه الشرف والعظمة والكثرة والارتفاع سمي تعالى بذلك لكثرة جلاله وشرفه وعلوه بما يخرج عن طوق البشر واختلف العلماء هل هو صفة خاصة كالعلم والقدرة أو هو عبارة عن استجماع صفات المعالي ووجوه نفي النقائص فلا كمال إلا له ولا نقص إلا وهو منزه عنه
وقوله بالعظمة والجلال متعلق بتمجيد واسم العظيم نطق به القرآن والسنة وهو تعالى عظيم في ذاته وصفاته وقهره وسلطانه فكل عظيم بالنسبة إلى عظمته عدم محض واسم الجميل لم يرد في القرآن ولا في حديث أبي هريرة لكن في الحديث إن الله جميل يحب الجمال وورد أيضا في بعض طرق أبي هريرة
ولما كان تعالى كاملا في ذاته وصفاته وأفعاله وصف بالجمال وهو تعالى مقدس عن الصورة وعن الصفات البشرية
ومشاهدة صفة الجمال يثير المحبة ومشاهدة صفة الجلال يثير الهيبة والعظمة تثير الهيبة أيضا فلهذا قرن المصنف العظمة بالجلال لتفيده معنى زائدا على الجلال فالباء يحتمل أن تكون بمعنى في أي تمجد في عظمته وجلاله فارتفع بهما على كل عظيم وجليل ويحتمل أن تكون للسببية على معنى أنه ارتفع بعظمته وجلاله على كل شيء فلا شيء إلا وهو مجد تعالى وهو تعالى مجيد بذاته عظيم بذاته فليس المعنى أن بعض الصفات أثر في بعض وإنما لما كانت هذه الصفات تشير إلى مجموع معان وملاحظة كل منها يوجب العلم بالكمال بها حسن ذلك كله
وتنزه من تفرد بالقدم والكمال التنزيه بمعنى التسبيح وقد ورد مصرحا
به في الحديث أنه كان يصلي من الليل فلا يمر بآية فيها تنزيه لله إلا نزهه وأصل النزهة البعد وتنزيه الله تبعيده عن ما لا يليق به ولا يجوز عليه فمعنى تنزه بعد والتفرد الانفراد يقال تفرد به واستفرد به بمعنى واحد والقدم وجود لا أول له وكل شيء سوى الله وصفاته فهو حادث لوجوده أول وصفاته لا يقال فيها إنه غيره والكمال المطلق ليس إلا لله تعالى فهو الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله وكل ما سواه مفتقر إليه والافتقار ينافي الكمال فله حدوثه عن العدم وغير ذلك مما للمخلوق من صفات النقص
عن مشابهة الأشباه والأمثال ومصادمة الحدوث والزوال هذا متعلق بقوله تنزه وأما تقدس فإما أن يجعل كلاما تاما وإما أن يجعل من باب التنازع ويضمر في تقدس كما ذكره هنا والمشابهة المشاكلة والشبه الشبه والشبيه بمعنى واحد وهو ما يشبه الشيء وبينهما شبه بالتحريك وكل منها يجمع على أشباه والمثل والمثل كالشبه والشبه وهو ما يساوي الشيء ويقوم كل منهما مقام الآخر في حقيقته وما هيته كالأجسام متساوية في الجسمية وإن اختلفت بالألوان والأشكال وغيرها من الأعراض واختلافها بذلك لا يخرجها عن التماثل في الحقيقة هذا حقيقة المثلين وبه تزول شبهات يوردها المجسمة وكثير ممن وقع في التشبيه ظانا أنه سالم منه والمصادمة المماسة والمراد بها ههنا الإلصاق واللحاق والحدوث وجود مسبوق بعدم فهو ضد الأزلية والزوال طريان العدم وهو ضد الأبدية والأولية والأبدية واجبان لله تعالى لأنه يقال واجب لذاته يستحيل عليه العدم لا أولا ولا آخرا
مقدر الأرزاق والآجال ومدبر الكائنات في أزل الآزال هذا مما لا يجحده مسلم ولا كافر تفرد الرب سبحانه وتعالى به وما فيه من عظيم العلم والقدرة والمنة والأزل المقدم والأزل القديم وأصل هذه الكلمة قولهم للقديم لم يزل ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا باختصار قالوا يزلي ثم أبدلت الياء ألفا لأنها أخف فقالوا أزلي كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن أذني وقوله ألآزال على سبيل المبالغة في اللفظ
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الغيب والشهادة قيل السر
والعلانية وقيل الدنيا والآخرة وقيل ما غاب عن العباد وما شهدوا وقيل الغيب المعدوم والشهادة الموجود والمدرك كأنه مشاهد والكبير الكامل في ذاته وصفاته المتقدم في المنزلة والسبق في المرتبة من كبر بضم الباء والمتعال المستعلي على كل شيء بقدرته كبر عن صفات المخلوقين وتعالى عنها
نحمده على فضله المترادف المتوال على ما عمنا من الأنعام والأفضال الحمد الثناء بجميل الصفات والأفعال ولا يكون إلا بالقول سواء كان ذلك الجميل في المحمود خاصة به أو كان واصلا منه إلى غيره والثاني شكر والشكر يكون بالقول والفعل والإعتقاد فبينه وبين الحمد عموم وخصوص من وجه وبين الحمد والمدح فرق آخر أدعاه السهيلي وهو أن الحمد يشترط فيه أن يكون صادرا عن علم وأن تكون الصفات محمودة صفات كمال ولهذين الشرطين لا يوجد الحمد لغير الله والله هو المستحق الحمد على الإطلاق والمدح قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كان فيها نقص ما والإتيان بالنون في هذا الفعل ينبغي أن يقصد به أن جميع الخلائق حامدون وليست للتعظيم والمترادف المتتابع والمتوالي كذلك فينبغي أن يكون مقصوده بالمترادف الذي يأتي بعده في أثر بعض ليسلم من التأكيد ويفيد كثرة الفضل في الزمان الواحد واستمرار ذلك في كل زمان وفضل الله هكذا هو وفي عمنا ضمير مرفوع عائد على الموصول أي عمنا هو ومن الأنعمام والأفضال بيان لذلك في محل رفع وقد قدمنا أن بين الحمد والشكر عموما من وجه وأنهما يتفقان فيما كان منه فيسمى حمدا وشكرا وقد استعمل المصنف هذا الحمد على ما هو منة واستعمل الشكر بالقول فتوافقا في هذا المحل وإن تغايرا في وصفهما والفضل من قوله واسألوا الله من فضله ومن قوله وكان فضل الله عليك عظيما والأفضال الإحسان والتفضل وقد استعمل الفضل على خلاف النقص فيكون الثناء عليه حمدا مباينا للشكر لكنه ليس المراد هنا لقوله المترادف المتوال فإنهما يقتضيان الوصول إلى الغير
ونصلي على محمد الهادي إلى نور الإيمان في ظلمات الكفر والضلال معنى نصلي هنا نطلب الصلاة من الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه و سلم سئل كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل م محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ومعنى نطلب إنشاء الطلب وكذلك نحمد معناه إنشاء الحمد وليس معناه الخبر فعطف إنشاء على إنشاء ووصفه صلى الله عليه و سلم بالهداية لقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وبين الهداية والضلال والنور والظلمات والإيمان والكفر ما لا يخفى من الطباق
وعلى آله وصحبه خير صحب وآل آله صلى الله عليه و سلم بنو هاشم وبنو المطلب هذا اختيار الشافعي وأصحابه وقيل عترته وأهل بيته وقيل جميع أمته وهو قول مالك والصحيح إضافة الآل إلى مضمر كما استعمله المصنف وقال جماعة من أهل العربية لا يصح إضافته إلا إلى مظهر والصحب جمع صاحب وهو كل من رأى النبي صلى الله عليه و سلم مسلما وقيل من طالت مجالسته والصحيح الأول بخلاف التابعي لا يكفي فيه رؤية الصحابي والفرق شرف الصحبة وعظم رؤية النبي صلى الله عليه و سلم وذلك أن رؤية الصالحين لها أثر عظيم فكيف روية سيد الصالحين فإذا رآه مسلم ولو لحظة انطبع قلبه على الاستقامة لأنه بإسلامه متهيء للقبول فإذا قابل ذلك النور العظيم أشرق عليه وظهر أثره في قلبه وعلى جوارحه
وقوله خير صحب وآل صحيح لأنه ليس في أصحاب الأنبياء مثل أصحاب نبينا صلى الله عليه و سلم ولأجل السجع قدم الصحب على الآل في الثاني وجاء على أحد طريقي العرب وهو رد الأول على الثاني والثاني على الأول ولولا هذا لقال خير آل وصحب فرد الأول للأول والثاني للثاني وهما طريقان للعرب جائزان
وبعد فأولى ما تهم به الهمم العوالي وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحار مشكلاته والفحص عن أستار أسرار معضلاته بعد ضم الدال على الصحيح مقطوع عن الإضافة أي بعد ما سبق من التقديس والتنزيه والحمد والصلاة والعامل فيه فعل مقدر تقديره أقول وهو معطوف بالواو على نحمد ونصلي وبعده فعل آخر مقدر تقديره تنبه هو معمول القول لأجله دخلت الفاء على أولى وفي الفاء فائدة أخرى وهي رفع توهم اضافة بعد إلى أولى
وقوله تهم بضم الهاء يقال هم بالأمر يهم هما أي أراده فأما بكسر الهاء فهو من الهميم وهو الدبيب والهمم جمع همة وهي الواحدة تقول همة مثل جلسة بالفتح للمرة وبالكسر للهيأة والجمع لها وإسناد الفعل للهمم وهو في الحقيقة لفاعلها من باب قولهم شعر شاعر والمعالم جمع معلم وهو ما جعل علامة للطرق والحدود مثل أعلام الحرم ومعالمه المضروبة عليه ويقال المعلم الأثر وهو راجع إلى معنى العلامة ولا خلاف في المعنى والمعالم الدينية الأدلة الشرعية وكل ما يهدي إليها وتعلمها تعرفها والملة الحنيفية هذه الملة قال صلى الله عليه و سلم بعث بالحنيفية السهلة السمحة وسميت حنيفية لأنها على ملة إبراهيم والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه السلام وسمي إبراهيم عليه السلام حنيفا لميله عن دين الصابئة وهم عباد الكواكب وسمى أتباعه حنفاء لذلك ولميلهم عن اليهودية والنصرانية قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما
والملة الدين والدليل على أن هذه الملة ملة إبراهيم قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وادعى بعض العلماء أنها موافقة لها في الأصول والفروع والمشهور أنها موافقة لها في الأصول فقط وعلى هذا لا اختصاص لملة إبراهيم بذلك لأن دين الأنبياء كلهم واحد في الأصول وإنما اختلفت
الشرائع في الفروع ويكون تسميته هذه الملة حنيفية لمخالفتها ما كان عليه أهل الشرك واليهود والنصارى كمخالفة إبراهيم من كان في زمانه من الكفار وهم الصابئة واتباعه دين الأنبياء قبله وبعده وهوالإسلام وحقائقها على هذا أصول الدين ولا تشمل أصول الفقه الذي تصدى له والمعالم الدينية شاملة له وإن جعلنا اسم الملة شاملا للأصول والفروع وكلا الأمرين أعني المعالم الدينية وحقائق الملة شاملا للأصول والفروع فيندرج فيه أصول الفقه الذي تصدى له وهو أحسن ليكون مناسبته للتصنيف الذي تصدى له أكثر ويشهد له قوله بعثت بالحنيفية السمحة فإنه يشير إلى الأصول والفروع جميعا ولا يلزم من ذلك موافقتها لشريعة إبراهيم في جميع الأشياء بل لموافقتها الأصول سميت بذلك وحقائقها على هذا جميع أحكامها ومعانيها وأسرارها والضمير في مشكلاته ومعضلاته عائد على الكشف لأن الأشكال والأعضال فيه لا فيها فإنها بينة جلية بيضاء نقية إذا ارتفع الحجاب عن الناظر رآها ولا خفاء بحسن استعاراته وترشيحها في الغوص في تيار البحار والفحص عن أستار الأسرار وكم من بحر لا يدرك له قرار وسر تتغيب في أستاره الأفكار
وإن كتابنا هذا منهاج الوصول إلى علم الأصول الجامع بين المعقول والمشروع والمتوسط بين الأصول والفروع المنهاج الطريق جعل علما على هذا الكتاب والوصول إلى الشيء إنما يكون عند انتهاء طريقه فقوله منهاج الوصول معناه الطريق التي يتوصل فيها إلى الوصول إلى علم الأصول كما تقول طريق مكة أي المتوصل فيها إلى مكة فليس الوصول فيه ولكنه غايته
وقوله منهاج خبر إن ويجوز إطلاق ذلك على هذا الكتاب بمعناه الأصلي غير علم لأن الاشتغال به يوصل إلى ذلك وقوله الجامع مخفوض صفة لعلم الأصول ولا خفاء في جمعه بين المعقول والمشروع فإنه نتج من نكاح نور الشرع لصافي بنات الفكر فجاء عريق الاصالة شديد البسالة وتوسطه بين الأصول أي أصول الدين والفروع وهذا يستمد من الأول ويمد الثاني
وهو إن صغر حجمه وكبر علمه وكثرت فوائده وجلت عوائده قوله
وهو يعني هذا الكتاب وصغر بضم الغين وكذلك كبر الباء لأنه بمعنى عظم وأصل كبر بضم الباء لكبر الجثة ثم استعمل في كبر المعنى وأما كبر السن فلا يقال فيه إلا كبر بكسر الباء وراعى المطابقة بين صغر وكبر لتضادهما واجتمعا لرجوع الصغر إلى الجثة والكبر إلى المعنى والعوائد جمع عائدة وهي العطف والمنفعة يقال هذا أعود عليك من كذا أي أنفع وفلان ذو عائدة أي تعطف ونفع وإن هذا الكتاب لكما وصف
جمعته رجاء أن يكون سببا لرشاد المستفيدين ونجاتي يوم الدين والله تعالى حقيق بتحقيق رجاءه وقوله حقيق بتحقيق أي خليق له وخليق وجدير وحري وحر كل ذلك بمعنى واحد وقصد المصنف التجانس بين حقيق وتحقيق وإطلاق ذلك على الله ينبئ على أن الأسماء توقيفية أولا
تعريف أصول الفقه
أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيدهذه العبارة بعينها عبارة تارج الدين الأرموي في الحاصل ولنقدم مقدمة وهي أنه ينبغي أن يذكر في ابتداء كل علم حقيقة ذلك العلم ليتصورها الذي يريد الاشتغال به قبل الخوض فيه فمن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل فلا جرم احتاج إلى تعريف أصول الفقه في أوله وههنا خمسة أشياء
أحدها لفظ أصول الفقه قبل أن يسمى به هذا العلم مركب من مضاف ومضاف إليه
والثاني هذا اللفظ بعد أن سمي به فإنه صار اسما للعلم وكل من المضاف والمضاف إليه بهذا الاعتبار صار كالزاي والدال من زيد لا معنى له وكل مركب سمي به معنى فقد يتطابق معناه حال التركيب وحال التسمية كعبد الله مسمى به رجل فهو صادق عليه بالاعتبارين وقد لا يتطابقان كأنف الناقة مسمى به رجل ولفظ أصول الفقه مما تطابق فيه معناه حال التركيب ومعناه حال التسمية من بعض الوجوه كما سنبينه
الثالث معنى أصول الفقه قبل التسمية
الرابع معنى أصول الفقه بعد التسمية مع قطع النظر عن أجزاء اللفظ المطلق عليه
الخامس معناه بعد التسمية مع الالتفات إلى أجزاء اللفظ المطلق عليه لأن اللفظ يدل عليه باعتبارين كما قدمناه فإذا أخذ المعنى بأحد الاعتبارين
كان مغايرا له بالاعتبار الآخر فيصدق على المعنى المذكور أنه إضافي لقبي باعتبارين لكن صدق اللفظ عليه بالإضافة إنما هو بطريق المجاز لأنه أخص من معناه الحقيقي والحد إنما هو للمعنى دون اللفظ فالمقصود بيان المعاني الثلاثة ويعبر عن المعنى الأول بالإضافي لأن المعنى مركب من مضاف ومضاف إليه في الذهن كما أن لفظه كذلك في النطق ويعبر عن المعنى الثاني باللقبي باعتبار أنه ملقب بهذا الاسم فإن اللفظ المركب جعل اسما عليه زلقبا له وعلما كسائر أعلام الأجناس أو أسماء الأجناس فإن علم الجنس هو الذي يقصد به تمييز الجنس من غيره من غير نظر إلى أفراده واسم الجنس الذي يقصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على أفراده حتى إذا دخلت عليه الألف واللام الجنسية الدالة على الحقيقة ساوى علم الجنس هذا هو الذي نختاره في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس ويستنتج منه أن علم الجنس لا يثنى ولا يجمع لأنه إنما يثنى ويجمع الأفراد وجعله اسم جنس أولى من جعله علم جنس لأنه لو كان علما لما دخلت عليه الألف واللام وكذلك سائر أسماء العلوم من فقه ونحو وغير ذلك ويعبر عن المعنى الثالث بالإضافي بالاعتبارين كما سبق
إذا عرفت هذه المقدمة فهمت ثلاثة مباحث
أحدهما في تعريف معنى أصول الفقه التركيبي قبل التسمية ولا بد في ذلك من تعريف المضاف والمضاف إليه والإضافة لأن العلم بالمركب يتوقف على العلم بالمفرد ونبدأ ذلك بتعريف المضاف وليس كما توهم بعض الناس من أنه يعتني بالبداءة بالمضاف إليه محتجا بأن المضاف يتعرف بتعريف المضاف إليه لأنا نقول التعريف تعريف مقابل التنكير وهو الذي يكتسبه المضاف من المضاف إليه وتعريف مقابل الجهل وهو المقصود هنا وهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف إليه فنقول الأصول جمع وتعرفه بتعريف مفرده والأصل ما يتفرع عنه غيره وهذه العبارة أحسن من قول أبي الحسين ما يبنى عليه غيره لأنه لا يقال إن الولد يبنى على الوالد ويقال إنه فرعه وأحسن من قول صاحب الحاصل ما منه الشيء لاشتراك من بين
الابتداء والتبعيض وأحسن من قول الإمام المحتاج إليه لأنه إن أريد بالاحتياج ما يعرف في علم الكلام من احتياج الأثر إلى المؤثر والموجود إلى الموجد لزم إطلاق الأصل على الله تعالى وإن أريد ما يتوقف عليه الشيء لزم إطلاقه على الجزء والشرط وانتفاء المانع وإن أريد ما يفهمه أهل العرف من الاحتياج لزم إطلاقه على الأكل واللبس ونحوهما وكل هذه اللوازم مستنكرة وكل هذه التعريفات للأصل بحسب اللغة وإن كان أهل اللغة لم يذكروها في كتبهم وهو مما ينبهنا على أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة
وأما في العرف فالأصل مستعمل في ذلك ولم يترك أهل العرف الاستعمال في ذلك لكن العلماء يطلقونه مع ذلك على شيئين أخص منه
أحدهما الدليل والثاني المحقق الذي يشك في ارتفاعه لتفرع المدلول على الدليل والاستصحاب على اليقين السابق
والفقه تعريفه سيأتي في كلام المصنف والإضافة تفيد الاختصاص فإن كان المضاف اسما جامدا أفادت مطلق الاختصاص كحجر زيد وإضافة الأعلام إذا وقعت من هذا القبيل كقول الشاعر ... علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم ...
وإن كان المضاف اسما مشتقا أفادت الإضافة اختصاص المضاف بالمضاف إليه في
المعنى المشتق منه كغلام زيد تفيد اختصاص الغلام بزيد في معنى الغلامية وكانت للملك وتفيد هنا اختصاص الأصول بالفقه في معنى لفظة الأصول وهو كون الفقه متفرعا عنه وظهر بهذا أن أصول الفقه بالمعنى التركيبي ما يتفرع عنه الفقه والفقه كما يتفرع عن دليله يتفرع عن العلم بدليله فيسمى كل منهما أصلا للفقه ولا فرق في الأدلة في هذا المقام بين الإجمالية والتفصيلية فإن كلا منهما يتفرع الفقه عنه وعن العلم به فصار أصول الفقه بالمعنى التركيبي يشمل أربعة أشياء الأدلة الإجمالية وعلمها والأدلة التفصيلية وعلمها وهذا ليس هو المصطلح ولا يصح تعريف هذا العلم بمدلول أصول الفقه الإضافي لأنه أعم منه إلا إذا أخذ بعد التسمية كما سيأتي
البحث الثاني في تعريف معنى أصول الفقه اللقبي وهو المصطلح عليه ولا شك أن كلا من الأدلة التفصيلية والعلم بها غير داخل فيه لأن ذلك من وظيفة الفقيه والخلافي فلم يوضع أصول الفقه في الاصطلاح لكل ما يحتاج إليه الفقه بل لبعض ما يحتاج كدأب أهل العرف في تخصيص الأسماء العرفية ببعض مدلولاتها في اللغة والأدلة التفصيلية مثل أقيموا الصلاة ودلالته على وجوب الصلاة ونحو ذلك ولما استفيد إخراج الأدلة التفصيلية و علمها من الوضع تبقى الإجمالية وعلمها والمراد بالإجمالبة كليات الأدلة فإن قوله أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا اقتلوا المشركين ونهيه صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء والصبيان وإطلاق الرقبة في موضع وتقييدها بالإيمان في موضع وصلاته صلى الله عليه و سلم في الكعبة وإجمال الصلاة في الآية المذكورة وبيان جبريل لها ونسخ التوجه إلى بيت المقدس والإجماع على أن بنت الابن لها السدس مع الثلث عند عدم العاصب وخبر ابن مسعود في ذلك وقياس الأرز على البر ومرسل سعيد بن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وقول عثمان في بيع الفراء والمصلحة المرسلة في التترس والأخذ بالأخف في دية اليهودي والاستحسان في التحليف على المصحف ونحو ذلك كلها أدلة معينة وجزئيات مشخصة والعلم بها ليس من أصول الفقه في شيء وإنما هي وظيفة الفقه ولهذه الأدلة وأمثالها كليات وهي مطلق الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والفعل والإجمال و التبيين والنسخ والإجماع وخبر الواحد والقياس والمرسل وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والأخذ بالأخف والاستحسان عند من يقول به وهذه الكليات داخلة في الجزئيات فإن الكلي الطبيعي موجود في الخارج وفي الذهن في ضمن مشخصاته ففي الأدلة اعتباران
أحدهما من حيث كونها معينة وهذه وظيفة الفقيه وهي الموصلة القريبة
إلى الفقه والفقيه قد يعرفها بأدلتها إذا كان أصوليا وقد يعرفها بالتقليد ويتسلمها من الأصول ثم هو يرتب الأحكام فمعرفتها حاصلة عنده
والاعتبار الثاني من حيث كونها كلية أعني يعرف ذلك الكلي المندرج فيها وإن لم يعرف شيئا من أعيانها وهذه وظيفة الأصولي فمعلوم الأصولي الكلي ولا معرفة له بالجزئي من حيث كونه أصوليا ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة له بالكلي من حيث كونه فقيها ولا معرفة له بالكلي إلا لكونه مندرجا في الجزئي المعلوم وأما من حيث كونه كليا فلا فالأدلة الإجمالية هي الكلية سميت بذلك لأنها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل وهي توصله بالذات إلى حكم الإجمالي مثل كون كل ما يؤمر به واجبا وكل منهي عنه حراما ونحو ذلك وهذا لا يسمى فقها في الاصطلاح ولا توصل إلى الفقه بالتفصيلي وهو معرفة سنية الوتر أو وجوبه والنهي عن بطلان بيع الغائب أو صحته مثلا إلا بواسطة فقبدية الإجمال مأخوذة في الأدلة والمعرفة معا أيضا وليست مأخوذة في الفقه ولذلك لا يلزم من النظر في الأصول حصول الفقه والحكم الكلي متوقف على الأصول توقفا ذاتيا والحكم التفصيلي وهو الفقه موقوف عليه أيضا وعلى غيره كلية قد يكون بالتقيد للأصولي كما أشرنا إليه وبهذا يظهر أن الاجتهاد في الفقه على الإطلاق شرطه الأصول ومعرفتها بالاجتهاد وأما بدون ذلك فيكون مقلدا وإن اجتهد في تفريع المسائل
ثم هذه الأدلة الكلية لها حقائق في أنفسها من حيث دلالتها وتعلق العلم بها فهل وضع أصول الفقه لتلك الحقائق في أنفسها أو للعلم بها كلام المصنف يقتضي الثاني وكلام الإمام وغيره يقتضي الأول ولكل منهما وجه فإن الفقه كما يتوقف على الأدلة يتوقف على العلم بها وقد يرجح ما فعله المصنف بأن العلم بالأدلة لا يوصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها لأن الفقه علم لكن أهل العرف يسمون المعلوم أصولا وكذلك يسمون المعلوم فقها ونقول هذا كتاب أصول وكتاب فقه والأولى جعل الأصول للأدلة والفقه للعلم لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي ثم الأدلة لها اعتباران أحدهما حقيقتها في نفسها والثاني من حيث دلالتها على الفقه والمأخوذ في حد أصول الفقه والمأخوذ في حد أصول الفقه إنما هو هذا الثاني وهو مستفاد من الإضافة
في قولنا أدلة الفقه لما قدمناه أن الإضافة تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه في معنى لفظة المضاف فالشرط في الأصولي معرفة أدلة الفقه من حيث دلالتها على الفقه خاصة وقد يكون لها عوارض أخرى لا يجب معرفته بها ثم معرفة الأدلة من حيث كونها أدلة لا بد معه من كيفية الاستدلال ومعظمها يذكر في باب التعارض والترجيح فجعلت جزءا آخر من أصول الفقه لتوقف الفقه عليها وليس كل أحد يتمكن من الاستدلال ولا يحصل له الفقه بمجرد علم تلك الأدلة وكيفية الاستدلال لأنها أدلة ظنية ليس بينها وبين مدلولاتها ربط عقلي فلا بد من اجتهاد يحصل به ظن الحكم فالفقه موقوف على الاجتهاد والاجتهاد له شروط يحتاج إلى بيانها فجعلت جزءا ثالثا من أصول الفقه لتوقف الفقه عليها
وهذا مجموع ما يذكر في أصول الفقه الأدلة وكيفية الاستدلال وكيفية حال المستدل والإمام ومن وافقه يجعلون أصول الفقه عبارة عن الثلاثة والمصنف وطائفة يجعلونه عبارة عن معرفة الثلاثة فالمعارف الثلاثة عندهم هي أصول الفقه وقد تقدم البحث في ذلك
فقول المصنف وكيفية الاستفادة معطوف على دلائل الفقه أي ومعرفة كيفية الاستفادة وكذا قوله وحال المستفيد أي ومعرفة حال المستفيد والمراد بالمستفيد المجتهد لأنه الذي يستفيد الأحكام من أدلتها ويقع في بعض النسخ حال المستدل وفي بعضها حال المستفيد فجمع بعض النساخ بينهما واقتضى هذا الغلط أن يحمل المستدل على المجتهد والمستفيد على المقلد لأنه يستفيد من المجتهد لكن يجوز أن يكون جزءا من أصول الفقه بخلاف الاجتهاد فإن الفقه موقوف عليه نعم إذا عرف المجتهد عرف أن من سواه مقلد وهذا جاء بالعرض لا بالقصد أعني معرفة المقلد نعم بعض الناس قد سمى علم المقلد فقها فمن هذا الوجه يحسن إدراجه في أصول الفقه لتوقف فقهه عليه وفيه فائدة لا تذكر إلا فيه وهي حكمه إذا اختلفت عليه المجتهدون ونحو ذلك
وقول المصنف دلائل لو قال أدلة كان أحسن لأن فعيلا لا يجمع على
فعائل إلا شاذا وقوله إجمالا مصدر في موضع الحال أو تمييز من معرفة أو دلائل وكل منهما يصح أن يراد به على ما بينا ويزداد وعلى جعله من معرفة وجه آخر وهو أن يكون نعتا لمصدر محذوف تقديره عرفانا إجمالا وإعرابه تمييز أقوى لأنه يبين جهة الإضافة كقولك هذا أخوك رضاعة أو نسبا وهذا القيد أعني قوله إجمالا لإخراج العلم بالأدلة على التفصيل فليس من أصول الفقه ولا هو الفقه كما وقع في عبارة بعض شارحي هذا الكتاب لأن الفقه غيره بل هو يذكر في الفقه ومن وظيفة الفقيه وأصول الفقه الأدلة الإجمالية وعلمها وهل أصول الفقه بحسب الاصطلاح يصدق على القليل من ذلك والكثير أو لا يصدق إلا على المجموع اختيار الإمام الثاني فلم يجعل أصول الفقه يطلق على بعضه وهذا إنما يظهر بأخذ مضافا ومضافا إليه أما إذا أخذ إسما على هذا العلم فينبغي أن يصدق على القليل والكثير كسائر العلوم ولهذا إذا رأيت مسألة واحدة منه تقول هذا أصول فقه والاعتذار عن الجمع في لفظة الأصول بأمرين
أحدهما أن بعد التسمية لا يجب المحافظة على معنى الجمع
والثاني أنه جمع مضاف إلى معرفة فيعم والعموم صادق على كل فرد وكلام المصنف محتمل لما قاله الإمام ولما قلناه بالطريق المذكور
وعدول المصنف عن علم إلى معرفة نقدم عليه مقدمة وهي أن المعرفة تتعلق بالذوات وهي التصور والعلم يتعلق بالنسب وهو التصديق فإن أراد أن علم الأصول تصور محض فليس كذلك لأن العلم بكون الأمر للوجوب والنهي للتحريم من أصول الفقه وهو تصديق فالإتيان بلفظ العلم في هذا المقام
أحسن لأنه أعم من المعرفة ولهذا ينقسم العلم إلى التصور والتصديق ويقول النحاة في العلم إذا لم يكن عرفانا ثم سواء قلنا علم أو معرفة أو أدلة أو طرق كما قال الإمام يرد على جميع ذلك سؤال قوي وهو أن الطريق ما يفضي النظر الصحيح فيه إلى علم المدلول أو ظنه والدليل ما يفضي النظر الصحيح فيه إلى المدلول وعلم الدليل أو الطريق كذلك والمدلول هنا هو الفقه لقوله أدلة الفقه أو طرق الفقه وقد قدمنا أن الفقه بحسب الاصطلاح لا يصدق إلا على معرفة الأحكام التفصيلية فيلزم من هذا أن يكون أصول الفقه معرفة أدلة الأحكام التفصيلية وأن من عرفها عرف ضرورة بما قررناه من أن النظر في الدليل يوجب العلم بالمدلول فيلزم أن يكون الأصول فقها وأن يكون كل أصولي فقيها وهذا ظاهر البطلان ولا ينجى عن هذا قيد الإجمال في المعرفة أو في الدلالة لأن الإجمالي إن كان دليلا للتفصيلي لزم من تحصيله حصوله وإن لم يكن دليلا للتفصيلي فسدت إضافته إلى الفقه لأن الفقه تفصيلي ودليل الفقه مجموع أمرين
أحدهما الإجمالية والثاني التفصيلية والأول مندرج في الثاني فكل من علم الثاني علم الأول تقليدا أو اجتهادا ولا يحصل الفقه إلا بعلمهما والأصول في الأول فقط وقد سلم من هذا السؤال ابن الحاجب حيث قال إن حده لقبا العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ومع ذلك يرد عليه أن من القواعد النحوية وغيرها ما هو كذلك ولم تدخل في أصول الفقه فالحد غير مانع وغير جامع أيضا لأنه أخرج الأدلة عن الأصول جملة
فإن قلت هل من اعتذار عن المصنف والإمام وغيرهما في السؤال الذي قدمته قلت نعم وهو أن الأدلة التفصيلية التي يحصل عنها الفقه لها جهتان إحداهما أعيانها والثانية كلياتها وكل دليل هكذا فليست الأدلة منقسمة إلى ما هو إجمالي غير تفصيلي وتفصيلي غير إجمالي بل كلها شيء واحد له جهتان فالأصولي يعلمه من إحدى الجهتين والفقيه يعلمه من الأخرى ويصدق على ذي الجهتين أنه معلوم من وجه فالمراد بالأدلة التفصيلية التي هي موصلة إلى الفقه والأصولي يعرفها من جهة الإجمالي فلها اعتباران والنظر في
الدليل إنما يفيد العلم بالمدلول إذا نظر فيه على سبيل التفصيل والأصولي لم ينظر فيه كذلك فلم يحصل له الفقه لانتفاء شرط نظره لا لانتفاء كون المنظور فيه دليلا في نفسه وهذا جواب حسن مصحح لمعرفة الأدلة وإن كان جعله للأدلة صحيحا أيضا باعتبار أن للأدلة نسبتين كما قدمنا فهي باعتبار إحدى النسبتين غيرها باعتبار الأخرى هذا كله في تعريف المعنى اللقبي إذا قطعنا النظر عن أجزاء اللفظ وكذلك إذا لاحظناها مع التخصيص الذي أشرنا إليه فيما سبق فإن التعريف يحصل بما ذكره أيضا وليس من شرط الحد أن يكون بأجزاء محمولة كما ظنه بعضهم بل بأجزاء داخلة في الحقيقة وأجزاء المحدود هنا وهي المعارف الثلاث كذلك والمعرفة جنس الأصول وما أضيف إليه من الأدلة والكيفيتين فصول تقديره معرفة متعلقة بالأدلة والكيفيتين فالمتعلقة فصل وإنما جعلناه فصلا لأن التعلق داخل في ذات العلم فإن جعلته خارجا كان خاصة وكان التعريف رسما تاما
البحث الثالث
في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها وما بينها من النسبأما المعنى الأول وهو معنى أصول الفقه قبل التسمية فهو أعم مطلقا من الثاني والثالث اللذين هما بعد التسمية وتعريفه أعم من تعريفهما ولا يحصل به تعريف هذا العلم كما سبق وإطلاقه عليه إطلاق الأعم على الأخص ولم يذكر المصنف ولا غيره ممن أراد تحديد علم أصول الفقه ذلك إلا على سبيل التقدمة كما فعله الإمام فإنه ذكر المفردات ثم ذكر تعريف أصول الفقه بعد مسمى به ولذلك أخذ فيه قيد الإجمال ولو راعى مدلوله قبل التسمية لم يأخذ فيه قيد الإجمال وأما معناه اللقبي ومعناه الإضافي بعد التسمية إذا لوحظت أجزاء لفظه فهما سواء وتعريفهما سواء فسرنا الأصول بالأدلة أم بالمحتاج إليه فيصح على كل من التقديرين هذا أن نجعل أصول الفقه اسما للأدلة وهي محتاج إليها فيتحد المعنى اللقبي والإضافي أما الإضافي فظاهر وأما اللقبي فلتسمية الأدلة بذلك ويصح أن نجعله اسما للمعرفة فيتحدان أيضا أما اللقبي فظاهر وأما الإضافي فظاهر إن جعلنا الأصل المحتاج إليه وإن جعلناه الدليل فنكون قد سمينا به العلم بالدليل من باب تسمية العلم باسم المعلوم
فإن قلت إذا جعلنا الأصول للأدلة والتسمية للمعرفة تغاير المعنى اللقبي والإضافي قطعا فيجب أن يكون لكل منهما حد قلت ليس المراد بالإضافي معناه قبل التسمية وإلا لورد المعنى الأول وقد قدمنا أنه خارج قطعا فإنما المراد تعريف المعنى اللقبي باعتبار ملاحظة أجزاء اللفظ فلا بد أن يوجد فيها تعبير إما بمجاز أو بتخصيص حتى يوافق اللقب وحينئذ يتحد التعريفان ويستحيل أن يكون لعلم أصول الفقه المصطلح عليه حدان أحدهما باعتبار الإضافة قبل التسمية والثاني باعتبار اللقب
تعريف الفقه
والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيليةفي معنى الفقه بحسب اللغة ثلاثة أقوال
أحدها مطلق الفهم
والثاني فهم الأشياء الدقيقة
والثالث فهم غرض المتكلم من كلامه وقولنا غرض المتكلم من كلامه إشارة إلى أنه زائد على مجرد دلالة اللفظ الوضعية فإنه يشترك في معرفتها الفقيه وغيره ممن عرف الوضع وبهذا الاعتبار يسلب عمن اقتصر على ذلك من الظاهرية اسم الفقيه وأما في الاصطلاح فقد ذكره المصنف والكلام عليه من وجوه
أحدها قوله العلم جنس يشمل التصور والتصديق القطعي وإنما قلنا ذلك لأن العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض ويلزمها التعلق بمعلوم فإن كان المعلوم ذاتا أو معنى مفردا أو نسبة غير خبرية فهو التصور وإن كان نسبة خبرية فهو التصديق القطعي مثاله العالم حادث وههنا أربعة ذات العالم ومعنى الحدوث في نفسه والارتباط بينهما من غير حكم بثبوته أو بانتفائه والعلم بهذه الثلاثة تصور والرابع هو ثبوت ذلك الارتباط أو انتفاؤه وهو النسبة الخبرية وهو التصديق وهكذا في كل قضية موضوعها ومحمولها مفردا والارتباط بينهما نسبة تقييدية وهو من قبيل المفرد ووقوع تللك النسبة
أو عدم وقوعها أمر رابع فتعلق العلم بتلك الثلاث تصور وتعلقه بالرابع تصديق والفرق بين الثالث والرابع دقيق فإنك تقول علمت حدوث العالم بمعنى تصورته وعلمت حدوث العالم بمعنى صدقت به فالنسبة واحدة ولكن التصور علمها في نفسها والتصديق علم حصولها فحقيقة المعلوم في التصديق كحقيقة المخبر به في الخبر بل هي حقيقة واحدة إن تعلق بها الكلام سمي خبرا وإن تعلق بها العلم سمي تصديقا والتصور أخص من العلم مطلقا والتصديق أخص منه من وجه لأن التصديق قد يكون بالخبر وليس بعلم لخروجه من حد العلم وتفسير التصديق بما قلناه وهو العلم بالنفي والإثبات يصحح انقسام العلم الذي هو الإدراك إلى التصور والتصديق بخلاف ما إذا فسرناه بالحكم أو بالحكم مع التصور فلا يصح انقسام العلم إليه إلا إذا قيل إن العلم بالنفي او الإثبات حكم والمعروف أن الحكم إيقاع النسبة
وكشف اللبس في ذلك أن الحكم هو نسبة أمر إلى أمر بالإثيات أو النفي وهو قسم من أقسام الكلام قد يكون بالنفس وقد يكون باللسان فإذا قلنا حكم الذهن فإنما نريد الإخبار النفساني ثم إن هذا الإخبار محتمل للتصديق والتكذيب والتصديق والتكذيب إما بالإخبار بأن يقال لقائله صدقت أو كذبت وإما بالعلم والاعتقاد فإن من علم صدق المخبر يقال له مصدق له ومن علم كذبه يقال أنه مكذب له فسمى العلم المتعلق بذلك الخبر أو بمضمون الخبر تصديقا لما قلناه لأنه مصدق له فالعلم يتعلق بالحكم أو بمضمونه لا ينقسم إليه وقولنا بمضمونه لأن العلم قد يتعلق بالنسبة الخارجية وقد يتعلق بالخبر عنها فالثاني تصديق للخبر والأول تصديق لمضمونه والحكم منه ما هو تصديق وهو الاخبار بصدق الصادق ومنه ما ليس بتصديق وهو تقييد الأحكام وأنما شاع في العرف إطلاق التصديقات على القضايا مطلقا لأنها قابلة لأن تصدق فكأنهم قالوا الصادقة ومن هنا يتبين أن أحق القضايا باسم التصديق ما كان مقطوعا به لأنه الذي يصدقه العلم أما المظنونة والمشكوك فيها والموهومة فلا يوثق بأيها إذا عرضت على العلم بصدقها أو بكذبها فإن أطلق عليها اسم التصديق فإنما هو بطريق احتمالها له وإنما تسمى حكما وجميع الأشياء معروضة على العلم وهو الميزان لها فالمفردات بتصورها والأحكام الصحيحة بصدقها والباطلة بصدق نقيضها
ولما كان دائما في القضايا مصدقا لها ولنقيضها سمي تعلقه بها تصديقا وترك لفظ التكذيب للاستغناء عنه بنقيضه ولهجر لفظه وإنما سمى العلم بالصدق تصديقا لأن به يصدق فهو الأصل في الأصل في التصديق وإطلاق التصديق على الحكم بالصدق للزومه له وإطلاقه على الحكم بذلك بطريق الظن فيه بعيد وإطلاقه على الحكم مطلقا سواء كان تصديقا بخبر أم لا بعيد عن اسم التصديق
وقد أطلنا في هذا لأنا لم نجد من حققه هكذا
وفي العلم اصطلاح آخر خاص لا يندرج فيه التصور يقال فيه الاعتقاد الجازم المطابق لموجب وهذا هو أحد قسمي العلم العام وهو العلم التصديقي فإنا قدمنا أنه لا بد وأن يكون قطعيا فقولنا جازم مخرج الظن والشك والوهم وقولنا مطابق مخرج الجهل وقولنا لموجب مخرج التقليد
ومنهم من يقول الثابت بدل قولنا لموجب لأن اعتقاد المقلد غير ثابت لأنه يمكنه اعتقاد نقيضه واليقين لا يمكن اعتقاد نقيضه وهذا النوع من العلم لا يكون معلومه إلا حكما بإسناد أمر إلى أمر محتملا للتصديق والتكذيب أو مضمون ذلك الحكم وهو وقوع تلك النسبة في نفس الأمر كما بيناه
إذا عرفت الاصطلاحين في العلم فلك أن تجعله في كلام المصنف بالمعنى الأعم ويخرج التصور بما بعده وهو الذي سلكه الإمام وعليه سؤال سنورده ولك أن تجعله بالمعنى الأخص فلا يكون التصور داخلا فيه ولا يكون قوله بالأحكام مخرجا لشيء بل توطئة للشرعية وعلى كلا التقديرين لا يندرج الظن فيه ولذلك أورد عليه السؤال الذي سيأتي
وقد يطلق العلم باصطلاح ثالث على الصناعة كما تقول علم النحو أي صناعته فيندرج فيه الظن واليقين وكل ما يتعلق بنظر في المعقولات لتحصيل مطلوب يسمى علما ويسمى صناعة وعلى هذا الاصطلاح لا يرد سؤال الظن لكنهم كلهم أوردوه فكأنهم لم يريدوا هذا الاصطلاح أو أرادوه ولحظوا معه معنى العلم في الأصل ويطلق النحاة العلم أيضا على المعرفة وقد أصابوا
ولكن ليس فيها اعتقاد ولا ظن بل تصور محض ولا يجوز أن تكون هي المراد ههنا لأن الفقه تصديق لا تصور
الوجه الثاني من الكلام على التعريف الباء في قوله بالأحكام ولنقدم مقدمة وهي أن علم فعل متعد بنفسه وأما الباء في قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى فاحتمل زيادتها واحتمل بأن يكون علم مضمنا معنى أحاط ومما يتنبه له إن علم المتعدية إلى مفعولين لم يدخلوا الباء على واحد من مفعوليها إذا ذكرا صريحين ودخلت على أن وصلتها السادة مسدهما لدلالتها على النسبة التي هي المعلومة وهذا يقوي التضمين ويقوي قول أكثر النحويين أنها سادة مسد المفعولين ويضعف قول من يقدر معها مفعولا ثانيا لأن المفعول الأول لا يدخل عليه الباء وليس هو المعلوم أعني المخبر بعلمه إنما المخبر بعلمه نسبة الثاني إليه وإذا علمت قيام زيد بمعنى أنه قام أو يقوم جاز دخول الباء في المفعول كما يدخل على إن لأن المعلوم فيهما ثبوت النسبة وإذا كانت علم بمعنى عرف جاز دخول الباء على مفعولها وتكون زائدة كقولك عرفته وعرفت به فإن أردت غيره صح أن يكون علم على حقيقتها
إذا علمت هذا فدخولها في قوله العلم بالأحكام لا بد منه أما على طريقة التضمين في الفعل فظاهر وأما على طريقة الزيادة في الفعل فلأن المصدر المعرف بالألف واللام ضعيف العمل جدا وإذا ضعف تقوى بالحرف كقوله إن كنتم للرؤيا تعبرون و مصدقا لما بين يديه وعلى كل تقدير هي متعلقة بالعلم وأما تقدير محذوف يتعلق به كقولنا العلم المتعلق بالأحكام فلا حاجة إليه إلا إذا فسرنا العلم بالصناعة فيظهر تقديره
الوجه الثالث قوله بالأحكام يخرج به العلم بالذوات والصفات الحقيقية والإضافية غير الحكم والأفعال وإنما قلنا غير الحكم لأن الحكم الشرعي كلام يتعلق به فهو صفة عرضت لها الإضافة
وهنا تنبيهات منها أن الحكم يطلق على النسبة الخبرية وهي معلوم التصديق وبه يخرج التصور كله وعلى إنشاء الأمر والنهي والتخيير ومنه الحكم الشرعي والعلم قد يتعلق به على جهة التصور ألا ترى إلى قول المصنف ولا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها وعلى هذا لا تكون الأحكام مخرجة للتصورات وإنما تخرج بقوله بعد ذلك المكتسب من أدلتها فإن التصور يكتسب من التعريفات لا من الأدلة وعلى كل من تكلم على الحد جعل قوله الأحكام مخرجا للتصورات هذا سؤال قوي وجوابه أن الحكم لفظ مشترك والمراد به ههنا المعنى الأول
فإن قيل الألفاظ المشتركة لا تستعمل في الحدود من غير بيان وأيضا قال الفقه العلم بالأحكام الشرعية ثم عرف الحكم الشرعي بالخطاب فاستحال أن يكون غيره وإلا لما انتظم قلت ينتظم من جهة أنه إذا عرفت أن الحكم الشرعي الخطاب الموصوف ترتب عليه حكما بثبوت ذلك الخطاب أو نفيه وهذا هو المراد بقولنا الفقه العلم بالأحكام الشرعية وسمي شرعيا لكونه لم يعرف إلا من الشرع والمتعلق به تصديق لا تصور والمذكور في حد الحكم هو حكم الله القائم بذاته وهو طلب أو تخيير وسمي شرعيا لأنه ناشئ من الشارع والعلم المتعلق به تصور وإنما ذكر لنعرف به الحكم المذكور في حد الفقه لتعلقه به والقاضي أبو بكر يجعل حكم الله إخباره يجعله الحكم لفعل كذلك فيستغني عن هذا التكلف وأما سؤال الإشتراك فهنا قرينة تبين المراد وهي أن الفعل متعد إلى مفعولين ولا يجوز دخول الباء على مفعوله إلا إذا تضمن نسبة بنفي أو إثبات كما تقدمت الإشارة إليه في الوجه الثاني فلما دخلت الباء هنا مع لفظ العلم الذي ظاهره التعدي إلى مفعولين على لفظ الحكم الذي هو ظاهر في النسبة كان ذلك قرينة على أن المراد بالأحكام ثبوتها لا تصورها ومن هنا يتبين لك أن المطلوب من الفقه علمه هو كون الشيء واجبا أو حراما أو مباحا وهو المذكور في حد الفقه ويقرب دعوى القطع فيه
لأن المراد العمل والمذكور في حد الحكم هو إيجاب الله أو تحريمه أو إباحته وهو صفة قائمة بذاته تعالى ويطلب تحقيقها من الأصولي لا من الفقيه والمطلوب تصورها ودعوى القطع في العلم بتعلقها بما علمه الفقيه غيره ولو قال قائل المراد بالأحكام هنا هو المذكور عند حد الحكم ونقدر بإثبات الأحكام ويستدل على هذا التقدير بما قلناه كان صحيحا والله أعلم
ومن التنبيهات أن الإمام ممن ادعى أن قوله بالأحكام يخرج العلم بالذوات والصفات ثم أورد السؤال كون الفقه مظنونا فيقال إن إراد بالعلم الاعتقاد الجازم فيرد سؤال الظن ولا يحسن وأن يقال خرج بالأحكام العلم والتصديق فيصح ما ادعاه من الإخراج ولا يرد سؤال الظن لأن الظن قسم من أقسام التصديق الذي هو قسم من العلم وجواب هذا بالتزام الثاني ومنع كون الظن من أقسام العلم بيناه في الوجه الأول
ومن التنبيهات أيضا أن بعض شرح من هذا الكتاب قال إن الأحكام تخرج العلم بالذوات والصفات كعلمنا بأن الأسود ذات والسواد صفة وهذه عبارة غير محررة فإن العلم بأن الأسود ذات والسواد صفة تصديق والعلم التصوري بنفس الذات ونفس الصفة متمثلة في الذهن
ومن التنبيهات أن الألف واللام في الأحكام للجنس هذا هو الذي نختاره والألف واللام الجنسية إذا دخلت على جمع قيل تدل على مسمى الجمع ويصلح للإستغراق ولا يقتصر به على الواحد والاثنين محافظة على الجمع والمختار أنه متى وقصد الجنس يجوز أن يراد به بعضه إلى الواحد ولا يتعين الجمع كما لو دخلت على المفرد نعم قد تقوم قرينة تدل على مراعاة الجمع مع الجنس فيقارب بذلك المفرد على ما قلناه ويصدق على العلم بحكم مسألة واحدة من الفقه أنها فقه ولا يلزم أن يسمى العالم به فقيها لأن فعيلا صفة مبالغة مأخوذة من فقه بضم القاف إذا صار له الفقه سجية وقال بعضهم إنها للعموم والمراد التمكن أي يكون له قوة قريبة من الفعل يصدق عليه بها للعلم بجميع الأحكام إذا نظر كما هي وظيفة المجتهد وهذا احسن في اسم فقيه اسم الفاعل المقصود
به المبالغة لا في اسم الفقه المصدر وقال بعضهم إنها للعهد والمراد جملة غالبة بحكم أهل العرف عندها يصدق الاسم وهذا ليس بشيء
ومن التنبيهات أن قولنا العلم بالأحكام يصدق على ثلاثة أشياء
أحدها تصور الأحكام وقد تحيلنا في إخراجه
والثاني إثباتها بمعنى اعتقاده أن الله أوجب وحرم وأباح من غير علم بأنه أوجب كذا أو حرم كذا أو أباح كذا وهذا أيضا ليس من الفقه في شيء بل هو من أصول الفقه
الثالث وهو المقصود إثباتها معينة لموضوعات معينة وقد عبر بعضهم عن هذا بقوله الأحكام الجزئية وأشار إلى أن هذا لا بد من زيادته في الحد
الوجه الرابع قوله الشرعية يخرج الأحكام العقلية مثل كون فعل العبد عرضا أو حسنا وغير ذلك والمراد بالشرعية ما يتوقف معرفتها على الشرع والشرع هو الحكم والشارع هو الله تعالى ورسوله مبلغ عنه فلذلك يطلق الشارع على الله وعلى رسوله صلى الله عليه و سلم وبما ذكرناه يندفع قول من قال إن الأحكام العقلية شرعية باعتبار أن الله خلقها وأنها تحت قضائه وقدره وقد وقفت على شرح لهذا الكتاب فيه أن قوله الشرعية احتراز عن الأحكام العقلية وتنبيه على أن المراد الأحكام بحسب الشرع لا بحسب العقل كما هو مذهب المعتزلة
وأعلم أن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام وإنما يقولون إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها فهي طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي فليس قوله الشرعية تنبيها على خلاف قول المعتزلة وإن كان قول المعتزلة باطلا ولعله استند في هذا إلى قول الإمام فإنه قال قولنا الشرعية احتراز عن العلم بالأحكام العقلية كالتماثل والاختلاف والعلم بقبح الظلم وحسن الصدق عند من يقول بكونهما عقليين وكلام الإمام هذا صحيح وسعناه أن الحسن والقبح لا يدركان بالعقل عندنا فلا يحترز عنهما وأما عند المعتزلة فيدركان بالعقل وهما حكمان عقليان يحترز عنهما وليس العلم بهما فقها والحكم الشرعي تابع لهما على رأي المعتزلة لا عينهما فما كان حسنا جوزه الشرع وما كان قبيحا منعه
فصار عند المعتزلة حكمان أحدهما عقلي والآخر شرعي تابع له والفقه هو العلم بالثاني فلذلك احترز عن الأول عندهم وكلام هذا الشارح يقتضي أنهم يطلقون على العلم بالأحكام العقلية فقها وليس كذلك فإذا تؤمل كلام الإمام كان ردا على ما قاله هذا الشارح وهذا المعتمد وغيره من كتب المعتزلة وفيها اعتبار الأحكام الشرعية في تعريف الفقه وقال هذا الشارح أيضا إن وجه نسبة الأحكام إلى الشرع أن تعلقاتها التنجيزية أو العلم بتعلقاتها التنجيزية مستفاد من الشرع لا أن نفس الأحكام أو تعلقاتها العلمية مستفاد من الشرع فإن الشرع حادث والأحكام وتعلقاتها العلمية قديمة والقديم لا يستفاد من الحادث انتهى ما قاله وكأنه لما رأى الأصحاب يقولون لا حكم قبل الشرع وأمثال هذه العبارة قاصدين لا حكم قبل البعثة توهم أن الشرع هو البعثة فقال إنه حادث وليس كما قاله ولا كما توهمه وإنما الشرع ما قدمناه
وأما قول الأصحاب فمرادهم به لا حكم قبل العلم بالشرع أو عبروا بالشرع عن البعثة على سبيل المجاز لأن بها يعرف ويظهر وهذا هو الأظهر من مرادهم وصاحب هذا الكلام لم يذكر كلام الأصحاب هذا ولكني أنا ذكرته جاحدا له ودفعته فإني استنكرت قول الشرع حادث أما سمع قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فإن كان الشرع حادثا فالحكم حادث وهو لا يقول به وإن قال به رد عليه ثم مضمون كلام هذا القائل أن يكون الأحكام في الأزل ثابتة وهي غير شرعية وهذا شيء لم يقل به أحد أما أن ذلك مضمون كلامه فلأنه صرح بأن الأحكام قديمة وفسر نسبتها إلى الشرع بشيء حادث وأما أن ذلك لم يقل به أحد فلأن الناس منهم من قال الحكم الشرعي قديم ومنهم من قال الحكم حادث أما قدم الحكم وحدوث كونه شرعيا فلا قائل به فإن قال نسميه شرعيا لأنه بصدد أن يستفاد من الشرع الحادث قلنا نسميه شرعيا لأنه حكم من الشارع الحقيقي القديم
الوجه الخامس قوله العملية قيل يم يذكره ابن الباقلاني وذكره غيره وقال الإمام أنه احتراز عن العلم بكون الإجماع حجة والقياس حجة فإن كل ذلك أحكام
شرعية مع أن العلم بها ليس علما بكيفية عمل وأشار الغزالي إلى ما أذكره وهو تبيين أن المراد بالأحكام الشرعية هنا ما استفيد من الشرع وهو أعم من تفسير الحكم الشرعي الذي سيأتي فإنه لو أريد ذلك لاستغنى عن قوله هنا العملية وأخص من مطلق الحكم ويصير لفظ الحكم الشرعي مشتركا بين ما ذكره هنا وهناك وكان شيخنا أبو الحسن الباجي يختار أن قيد العملية احتراز عن أصول الدين لأن منه ما يثبت بالعقل وحده كوجود الباري تعالى ومنه ما يثبت بكل واحد من العقل والسمع كالوحدانية ومنه وجوب اعتقاد ذلك ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع لقصور العقل عن معرفته فأما الأول والثاني فخرجا بقولنا الشرعية وتفسيرنا إياها بما هو متوقف على الشرع وأما الرابع فقد يقال إنه داخل في الشرعية والأولى أن يجعل هو والأولان خارجة عنها بأن يراد بالحكم الإنشائي لا الخبري ولا شيء من الثلاثة بإنشاء وأما وجوب اعتقاد ذلك فهو حكم شرعي إنشائي فإن كان ذلك لا يسمى فقها فلا بد من إخراجه وما في الحد ما يخرجه إلا القيد المذكور ويرد على إخراجها وإخراج أصول الفقه بذلك إن أريد بالعمل عمل الجوارح والقلب فلا تخرج لدخولها في أعمال القلوب وإن أريد عمل الجوارح فقط خرجت النية وكثير من المسائل التي تكلم الفقهاء فيها كالردة وغيرها مما يتعلق بالقلب ولذلك ترى الآمدي وابن الحاجب لفظ العملية وقالا الفرعية لأن النية من مسائل الفروع وإن كانت عمل القلب ولعل الفقهاء إنما ذكروا ذلك لما يترتب عليه من الصحة والبطلان والمؤاخذة المتعلقات بالأعمال كما يذكر في بعض العلوم ما يتعلق به من علم آخر ثم إن كون الإجماع حجه مثل كون الزنا سببا لوجوب الحد وقد
منع الإمام بعد ذلك أنه حكم شرعي فعلى طريقة لا حاجة له إلى إخراجه فطريق الجواب عنه أن مراده هناك أنه ليس بحكم زائد على أبحاث الحد وكذا كون الإجماع حجة معناه إيجاب العمل به وبمقتضاه فيجب الاحتراز عنه
الوجه السادس قوله المكتسب من أدلتها صفة للعلم وفي بعض النسخ المكتسبة صفة للأحكام والأول أحسن بل يتعين وإلا لاحتاج الحد إلى زيادة قوله إذا حصل بالاستدلال وعلى كلا التقديرين فهو احتراز عن علم الله تعالى وما يلقيه في قلب الملائكة والأنبياء من الأحكام من غير اكتساب واحتراز أيضا عن العلم بوجوب الصلاة والزكاة والصوم ونحوه مما هو معلوم من الدين بالضرورة لأن لفظ الفقه يشعر بالعلم بما فيه دقة ولا دقة في ذلك ولأن العوام يعلمون ذلك ولا تسمى فقهاء وقال التبريزي في هذا القسم المعلوم بالضرورة إنه فقه وإن لم يسم المتصف به فقيها فذلك لأن العلماء في اسم الفقيه عرفا كما أن لهم في اسم الفقيه عرفا وكون تلك العلوم ضرورية لا يخرجها عن كونها فقها فإن معظم علوم الصحابة شرائع الأحكام كان كذلك وهذا الذي قاله التبريزي هو المختار وإن ذلك يسمى فقها ولذلك يذكر في كتب الفقه وإنما لا يطلق على العالم به وحده اسم فقيه لما فيه من المبالغة وفقيه اسم فاعل من فقه بضم القاف إذا صار الفقه له سجية وهو وصف له في نفسه لا يتعدى إلى غيره والفقه هو مطلق الفهم وهو صفة يتعدى إلى المفهوم والضمير في أدلتها للأحكام ولو قال من أدلته لصح أيضا على ما في النسخ المشهورة من جعل المكتسب صفة للعلم
الوجه السابع قوله التفصيلية جعله الجمهور احترازا عن اعتقاد المقلد فإنه اعتبار وحكم شرعي عملي مكتسب من دليل إجمالي وهو أن هذا أفتاني به المفتي وكل ما أفتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي وهو دليل عام لا
يختص بمسألة بعينها ومقدمته الأولى حسية والثانية إجماعية ولذلك قال الإمام هنا إن هذا القيد يخرج ما للمقلد من العلوم فجعل الحاصل عند المقلد علما وأدرجه في جنس حد الفقه وأخرجه بهذا الفصل لكنه بعد ذلك جعله قسيم العلم فإنه لغير موجب والعلم لموجب وإذا لم يكن إعتقاد المقلد علما لم يدخل في الجنس وهو قوله العلم فلا يحتاج إلى إخراجه بالفصل إلا أن يريد بالعلم الإعتقاد الجازم المطابق أعم من أن يكون لموجب أولا وهنا تم الحد وعلى النسخة التي فيها المكتسبة بالهاء لا يتم الحد هنا لأن المسائل التي يعلمها المقلد هي مستدل عليها في نفس الأمر بأدلة تفصيلية مكتسبة لغيره فلا يخرج إلا بأن تقول إذا حصلت أو حصل علمها بالاستدلال
قيل الفقه من باب الظنون هذا سؤال على قوله العلم فاقتضى أنه لا شيء من الفقه بظني ونحن نبين لك أنه ظني لأنه موقوف على الظني والموقوف على الظني ظني أما كون الموقوف على الظني ظنيا فلأن الظني يحتمل العدم وعلى تقدير عدمه يعدم الموقوف عليه فلزم كونه ظنيا غير مقطوع به وأما كون الفقه موقوفا على الظني فلأنه موقوف على أدلته وأدلته نص أو إجماع أو قياس فالقياس كله ظني والإجماع اختلف فيه وعلى تسليم أنه قطعي فوصوله إلينا بالظن على أنه في غاية الندور والنص قسمان أحاد لا يفيد إلا الظن ومتواتر وهو مقطوع المتن ظنون الدلالة وإن اقترن به قرائن حتى أفاد العلم التحق بالمعلوم من الدين ضرورة وأنتم قلتم أنه لا يكون فقها ومقتضى ذلك أن يكون كل الفقه مظنونا ولا شيء منه بمعلوم على عكس ما اقتضاه الحد وفي بعض النسخ قيل من باب الظنون أي الفقه وحذفه لدلالة الكلام عليه
قلنا المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للديل القاطع على وجوب اتباع الظن فالحكم مقطوع والظن في طريقه مضمون هذا الجواب أن الفقه كله قطعي لا ظني وهذه المقالة تنسب إلى أكثر الأصوليين وحاصل كلامهم ومداره ما قاله المصنف وتقريره بالمثال أن نقول في الوتر مثلا الوتر يصلي على الراحلة فهو سنة فالوتر سنة والمقدمة الأولى ثابتة بخبر الواحد والثانية بالاستقراء وهما لا تفيدان إلا الظن فالنتيجة ظنية لتوقفها على الظن
وهذا الظن الذي أراده المصنف بقوله والظن في طريقه وأكثر الناس إذا وصلوا إلى هذه النتيجة وقفوا عندها واعتقدوا أنها الفقه وهو الظاهر من اصطلاح الفقهاء وعليه بنى السائل سؤاله والأصوليون لم يقفوا عند ذلك لأن الظن لا يجوز اعتماده حتى يدل عليه دليل فنظروا وراء ذلك وقالوا لما حصلت هذه النتيجة وهي اعتقاد كون الوتر سنة ظنا ركبنا قياسا آخر من مقدمتين هكذا الوتر مظنون سنيته وكل ما هو مظنون سنيته فهو سنة في حق من ظنه
والمقدمة الأولى قطعية لأنها وجدانية فإن الظان يجد من نفسه الظن كما يجد الجوع والشبع والمقدمة الثانية قطعية لقيام الإجماع على أن حكم الله في كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده وفي حق من قلده حتى لو اعتقد خلاف الإجماع لدليل كان حكم الله في حقه إلى أن يطلع على مخالفته وهذا الإجماع نقله الشافعي في الرسالة والغزالي في المستصفى وإذا تقررت المقدمتان كانت النتيجة الوتر سنة في حق من ظنه وهي قطعية لأنها تابعة لمقدمتين قطعيتين ولا يضرها وقوع الظن في مقدمتي القياس الأول ونتيجته وهي طريق القياس الثاني لأن الظن إنما يضر إذا كان في مقدمات الدليل وهنا مقدمتا القياس قطعيتان والمظنون خارج عنهما ووجود الظن الذي هو حاصل مقدمة القياس الثاني ليس مظنونا وهذا التقرير على حسنه إنما يفيدنا القطع بوجوب العمل فلذلك اختار جماعة أن الفقه هو العلم أو الظن والإنصاف أنهما مقامان اعتقاد كون الحكم عند الله كذا لا يمكن دعوى القطع فيه واعتقاد وجوب العمل بما ظنه من ذلك دعوى القطع فيه ممكنة والفقهاء نظروا للأول والأصوليون نظروا للثاني ولا مشاححة في الاصطلاح ولم يتوارد اختلافهما على شيء واحد على أني أقول قولهم حكم الله في حق كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده سبيله أنه يجب عليه اتباعه ودعواهم الإجماع بهذا التفسير صحيح وبغير هذا التفسير ممنوع فإذا قلنا المصيب واحد والمخطيء معفو عنه لا يستمر هذا الإطلاق وإن كان بعضهم قال إنه يتعين التكليف ولكن يجب حمله على أنه يأثم بترك ما ظنه واجبا وبفعل ما ظنه حراما لجراءته على ربه بحسب اعتقاده وأما أن ذلك يصير في حقه كالواجب والحرام في نفس الأمر فلا يمكن وإذا ظن زوجه أجنبيه فوطئها يأثم ولكن أيميز إثمه أو يساوي إثم الزاني
وقول المصنف للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن يقربه إلى الإجماع الذي جعلناه دليل المقدمة الثانية من القياس الثاني ومنع بعض الناس قطعيا قطعية هذا الدليل ليس يجمل لأنه لا بد لنا من دليل قاطع على اتباع الظن دفعا للتسلسل أو اثبات الظن بنفسه فلا بد من قاطع أما إجماع وحده وإما مع قرائن تحتف به تفيد القطع وهذا المعنى والتقرير يحصل في كل مسألة من مسائل الفقه سواء كان دليلها نصا أم قياسا أم غيرهما مما يفيد الظن وقوله مقطوع أي مقطوع به ولكنه حذف الجار وتوسع بتعدية الفعل إلى الضمير
ودليله المتفق عليه بين الأئمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس قوله المتفق عليه إشارة إلى أن ثم أدلة مختلفا فيها وسنذكرها وقوله بين الأئمة أي المعتبرين وإلا فقد أنكر بعض الناس القياس وبعضهم الإجماع ولعله لا يسمى من أنكر ذلك إماما وهو حق لأن الإمام من يقتدى به وهؤلاء لا يقتدى بهم فلذلك طلق الأئمة ووقع في بعض النسخ الأمة والأول أصح لبعد التجوز في الثاني
ولا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها لا بد أمعناه لا فراق ولذلك قال ابن عبد السلام إنه إذا حلف لا بد أن يفعل كذا ولم يفعله على الفور حنث والمختار أنها لا تفيد الفور المعروف والأصولي نسبة إلى الجمع لأنه مسمى به كالأنصاري والأنماري ولو لم يسم به لم تجز النسبة إلا إلى المفرد فيقال أصلي والحكم على الشيء بالإثبات أو النفي مسبوق يتصوره والأصولي يريد أن يثبت الوجوب مثلا للأمر والتحريم المنهى أو ينفيهما وكذلك بقية الأحكام فلذلك لا بد أن يتصورها أولا وقصد وبهذا وجه الحاجة إلى تقدم هذه المقدمة
لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب
الذي يسبق إلى الذهن من لا جرم في هذا الموضع أن معناها لأجل ذلك أي لأجل ما سبق رتبناه على كتب وقد جاءت لا جرم في القرآن في خمسة مواضع متلوة بأن واسمها ولم يجئ بعدها فعل والذي ذكره المفسرون واللغويون في معناها أقوال
أحدها أن لا نافية وجرم فعل معناه حق وأن ما في حيزه فاعلة وهذا مذهب الخليل وسيبويه والأخفش فقوله تعالى لا جرم أنهم معناه رد على الكفرة وتحقق بخسرانهم
والثاني أن لا زائدة وجرم معناه كسب أي كسب لهم عملهم الندامة فإن ما في حيزها على هذا القول في موضع نصب وعلى الأول في موضع رفع
الثالث أن لا جرم كلمتان ركبتا وصار معناهما حقا وكثيرا ما يقتصر المفسرون على ذلك
الرابع أن لا جرم معناه لا بد وإن الواقعة بعدها في موضع نصب بإسقاط حرف الجر قال الفراء لا جرم كلمة كانت في الأصل بمعنى لا بد ولا محالة فكثر استعمالها حتى صارت بمنزلة حقا تقول لا جرم لآتينك قال الواحدي وضع موضع القسم في قولهم لا جرم لافعلن كما قالوا حقا لأفعلن وأنت إذا تأملت هذه الأقوال لم ينطبق شيء منها على معنى التعليل الذي قصده المصنف والذي يظهر أن التعليل مستفاد من ترتيب الحكم على الوصف وتصحيح كلام المصنف بأن يقدر فلا جرم أنا رتبناه فإضمار الفاء لإفادة التعليل وتقدير أن واسمها لتوافق موقعها من القرآن أو ينزل الفعل منزلة المصدر ويستغنى عن إضمار أن والتقدير فحقا رتبناه والمقدمة بكسر الدال وفتحها وهو أشهر فالكسر لأنها تقدم الناظر فيها إلى ما بعدها والفتح لأن الناظر يقدمها بين يديه إلى مقصوده هذا في مقدمة الكتاب ومقدمة الدليل أما مقدمة الجيش فلم يجعل الجوهري فيها إلا كسر الدال لأنها تقدم الجيش
ووجه تقديم المقدمة في أول الكتاب كونه لا بد لكل أصولي من تصور الأحكام والكتب السبعة منها الأربعة التي قدمها الكتاب والسنة والإجماع والقياس كل منها كتاب
والخامس الأدلة المختلف فيها وهذه الخمسة هي الأدلة التي تضمنها المعرفة الأولى من أصول الفقه
والسادس في التعادل والتراجيح المقصود بالمعرفة الثانية
والسابع في الاجتهاد المقصود بالمعرفة الثالثة
وهذا جملة أصول الفقه
أما المقدمة ففي الأحكام ومتعلقاتها وفيها بابان
لما كانت متعلقات الأحكام يحتاج إليها ذكرها معها وإن لم يبين فيما سبق إلا وجه الحاجة إلى تصور الأحكام
الباب الأول في الحكم وفيه فصول
الفصل الأول في تعريفه
الحكم خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخييرلما كان الكلام في الحكم الشرعي لم يحتج إلى تقييده وقد تقدم الكلام في كونه إنشائيا أو خبريا وتفسيره بالخطاب وتقسيمه إلى الاقتضاء أو التخيير يدل على أن المراد الإنشائي والخطاب مصدر خاطب يخاطب خطابا مخاطبة وفي تسمية كلام الله تعالى في الأزل خطابا خلاف قال القاضي أبو بكر الكلام يوصف بأنه خطاب دون وجود مخاطب ولذلك أجزنا أن بكون كلام الله في أزله وكلام الرسول صلى الله عليه و سلم في وقته مخاطبة على الحقيقة وأجزنا كونه أمرا أو نهيا وعلى هذا لا يقال للموصي إنه مخاطب بما يودعه وصيته ويقال أمر من تفضي إليه الوصية انتهى فعلى هذا لا يصح أن يؤخذ الخطاب في حد الحكم لأن الحكم عندنا قديم ويجب أن يقال الكلام والمصنف تبع الإمام في لفظ الخطاب وكأن الإمام رأى أنه يقال في القديم باعتبار ما يصير إليه وإذا قلنا لا يطلق الخطاب في الأزل فهو يطلق بعد ذلك عند وجود المأمور والمنهي ينبغي أن يقال إن حصل إسماعه لذلك كما في موسى عليه السلام فيسمى خطابا بلا شك وإلا فلا على قياس قول القاضي وإذا سمينا ما يحصل إسماعه خطابا فلا يخرجه ذلك عن كونه قديما على أصلنا في جواز إسماع الكلام القديم وفي بعض نسخ الكتاب خطاب الله القديم كأنه رأى أن الخطاب يطلق على الكلام
القديم على غير مذهب القاضي وعلى الأصوات والحروف الدالة على ذلك وهي حادثة فقال القديم ليخرجها وفي بعض النسخ لم يقل القديم نظرا إلى أن الخطاب هو الكلام والكلام حقيقة في النفساني فقط وهو المشهور عند المتكلمين فلا حاجة إلى قوله القديم فحصل في الخطاب قولان
أحدهما أنه الكلام وهو ما تضمن نسبة إسنادية
والثاني أنه أخص منه وهو ما وجه من الكلام نحو الغير لإفادته وإضافته إلى الله بخرج خطاب غيره والمتعلق بأفعال المكلفين يخرج المتعلق بذاته تعالى والجمادات وذوات المكلفين وفعله كقوله الله لا إله إلا هو ويوم نسير الجبال ولقد خلقناكم والمراد بالمكلفين من كان بالغا عاقلا ولنا في الصبي خلاف هل هو مأمور بالصلاة والصوم بأمر الشارع أو بأمر الولي وعلى كل تقدير ليس تكليفا لأن أمر الندب لا كلفة فيه ومن رأى أنه مأمور بأمر الشرع قال في حد الحكم الخطاب المتعلق بأفعال العباد ولا يرد على المجنون لأنه لم يوجه له خطاب ومنهم من يقول بأفعال الإنسان لأن كلامنا فيما يتعلق بهم وإن كانت الملائكة والجن مكلفين لكنهم خارجون عن نظرنا
وقوله بالاقتضاء أو التخيير يخرج قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فإنه خطاب متعلق بأعمالنا على وجه الإخبار عنها بكونها مخلوقة لكنه ليس اقتضاء ولا تخييرا فخرج عن الحد والمراد بالاقتضاء الطلب فيشمل طلب الفعل إيجابا أو ندبا وطلب الترك تحريما أو كراهة والمراد بالتخيير الإباحة
قالت المعتزلة خطاب الله قديم عندكم والحكم حادث لأنه يوصف به ويكون صفة لفعل العبد ومعللا به كقولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق هذا سؤال على الحد مركب وعلى مقدمتين الأولى مسلمة وإن كانت المعتزلة لا يقولون بها فإنا نقول بقدم الكلام والثانية لا نقول نحن بها فاستدلوا عليها بثلاثة
أحدها أن الحكم يوصف به أي بالحدوث فنقول حلت هذه المرأة بعد أن لم تكن حلالا وحرمت بعد أن لم تكن حراما والبعدية تصريح بالحدوث
والثاني أنه أي الحكم يكون صفة لفعل العبد فتقول هذا الفعل حلال وهذا فعل حلال أو حرام والعبد حادث ففعله أولى أن يكون حادثا فصفة فعله أولى بأن تكون حادثة
والثالث أنه أي الحكم يكون معللا به أي بالحادث كقولنا حلت بالنكاح فالنكاح علة في الحل وحرمت بالطلاق فالطلاق علة في التحريم
وأيضا فموجبية الدلوك ومانعية النجاسة وصحة البيع وفساده خارجة عنها
هذا سؤال ثان وهو أن الحد غير جامع والحد يجب أن يكون جامعا لجميع أفراد المحدود مانعا من دخول غيره فيه فمتى خرج منه شيء أو دخل فيه غيره فيفسد والمراد بالدلوك زوال الشمس هذا هو الصحيح وقيل غروبها وكل منهما موجب لصلاة وغيره ذكر مع ذلك شرطية الطهارة والمراد أن هذه الخمسة أحكام شرعية غير الخمسة الأولى التي تضمنها الحد
وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد هذا سؤال ثالث على قوله بالاقتضاء أو التخيير أو للترديد والترديد ينافي التحديد لأن المقصود بالتحديد الإيضاح والبيان والمقصود بالترديد الشك والإبهام
واعلم أن مدلول أو إما شك كقولك جاء زيد أو عمرو وإما إبهام كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وإما تبيين قسمة كقولك العدد زوج أو فرد وإما إباحة كجالس الحسن أو ابن سيرين وإما تخيير كخذ درهما أو دينارا فالشك والإبهام منافيان للبيان بلا إشكال والتقسيم ليس فيه بيان المقسم والحد إنما يؤتى فيه بما يفيد البيان أو التخيير والإباحة لا محل لهما هنا وفيهما الترديد فلا يدخلان في الحدود
قلنا الحادث التعلق هذا جواب عن الوجه الأول من تقرير المقدمة
الثانية من السؤال الأول وهو أن الحكم يوصف بالحدوث فمنع ذلك وقال الحادث إنما هو التعلق فإذا قلنا حلت هذه المرأة بعد أن لم تكن حلالا فليس معناه أن إحلالها حدث وإنما معناه أنه تعلق بالعبد وهذا اختيار من المصنف أن التعلق حادث وهو المذكور في المحصول هنا وفي موضع آخر خلافه وهو المختار ولو كان التعلق حادثا لكان الخطاب المتعلق حادثا ضرورة أخذ التعلق قيدا فيه ويلزم على هذا أن يكون الحكم حادثا وهو قد فر منه وأن الكلام في الأزل لا يسمى حكما ومن ضرورته ألا يكون أمرا ولا نهيا ونحن لا نقول به ولا ينجى من هذا إلا أن يقال وصف الحكم في الأزل بالتعلق على سبيل الصلاحية ولكن هذا لا ضرورة إليه فالمختار أن الإحلال مثلا قديم وكذلك تعلقه وأن التعلق نسبة فهو يستدعي حصول متعلقه في العلم لا في الخارج وإنما الذي يحدث بعد ذلك الحل وهو غير الإحلال وإنما ينشأ عنه بشروط كلما وجدت وجد كما لو قلت أذنت لك أن تبيع عبدي هذا يوم الخميس فالإذن قبل الخميس موجود متعلق به وأثره يظهر يوم الخميس وعلى هذا يجب أن يحمل قولهم بحدوث التعلق فلا يكون بين الكلامين مخالفة في المعنى وكأن للتعلق طرفين من جهة المتكلم يتقدم ومن جهة المخاطب قد يتأخر
والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته كالقول المتعلق بالمعدومات
هذا جواب عن قوله ويكون صفة لفعل العبد فأجاب بأن الحكم قول متعلق بالفعل لا صفة للفعل لأن معنى الإحلال قول الله رفعت الحرج عن فاعله وهذا القول صفة لله تعالى قائم بذاته متعلق بغيره لا صفة كالقول
المتعلق بالمعدومات إذا أخبرت عنها مثلا فليس القول صفة لها وإلا لزم قيام الموجود بالمعدوم وأما كون للقديم متعلقا بالحادث فلا يمتنع
والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعالم للمصانع
هذا جواب عن الدليل الثالث وهو قوله ومعللا به أي بالحادث كقولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق فأجاب بأن هذه العلل شرعية والعلل الشرعية معرفات لا مؤثرات وكأن الله تعالى قال إذا تزوج فلان بفلانة بشروط كيت وكيت فاعلموا أني حللتها له فإذا وجد النكاح بتلك الشروط عرفنا الإحلال الأزلي ويجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم كما أن العالم يعرفنا وجود الباري سبحانه وتعالى ووحدانيته فليس علة له
واسم الصانع اشتهر على ألسنة المتكلمين في هذا المثال ولم يرد في الأسماء وقرئ في الشواذ صنعه الله بالنون فمن اكتفى في الأسماء بورود الفعل يكتفي بمثل ذلك وما ذكره المصنف من الجواب يحسن إيراده على وجهين
أحدهما على سبيل المنع ابتداء فيقال لا نسلم أن النكاح والطلاق ونحوهما علل وإنما هي معرفات
والثاني على سبيل الاستفسار فيقال إن أردت بالعلل المعرفات فمسلم ولا يفيدك وإن أردت المؤثرات فممنوع والعلة تطلق بمعنى المعرف والداعي والمؤثر والمتكلمون ينكرون المؤثر بناء على أن الأفعال كلها من الله تعالى وهو تعالى فاعل بالاختيار لا مؤثر بالذات ولا وجود للعلة المؤثرة هذا مذهب أهل السنة والحكماء وكثير من المتكلمين غير أن أهل السنة تثبتها وإلا اختلف مدركهم وهذا تمام الأدلة الثلاثة التي قرر بها السؤال الأول
والموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو وإن سلم فالمعنى بهما اقتضاء الفعل والترك وبالصحة إباحة الانتفاع وبالبطلان حرمته
هذا جواب عن السؤال الثاني بأحد طريقين إما بأن تلك الأشياء التي ادعى خروجها عن الحد ليست أحكاما بل إعلاما بالحكم فلا معنى لكون الدلوك واجبا إلا أن الله تعالى أعلمنا به الوجوب ولا معنى لكون الوضوء شرطا إلا أن الله أعلمنا بعدمه بطلان الصلاة وإما بأن نسلم أنها حكم ونقول إنها ليست خارجة عن الحد بل راجعة إليه بتأويل وهو أن المعني بالموجبية اقتضاء الفعل وبالمانعية اقتضاء الترك ومعنى هذا أن موجبية الدلوك مثلا بمنزلة جعلت الدلوك معرفا لوجوب الصلاة والاقتضاء المذكور في الحد معناه وجبت الصلاة عند الدلوك وحاصل العبارتين سواء فبذلك يكون الحد جامعا وكلام المصنف ناطق بهاتين الطريقتين في الموجبية والمانعية وأما الصحة والبطلان فاقتصر فيهما على الجواب الثاني وهو رجوعهما إليه بتأويل وهو أن صحة البيع لا معنى لها إلا إباحة الانتفاع وفساده لا معنى له إلا حرمة الانتفاع وفيه نظر لأنا نعلل إباحة الانتفاع بالصحة وحرمته بالفساد والعلة غير المعلول ولأن بتمام الإيجاب والقبول تحصل الصحة ولا يباح الانتفاع حينئذ حتى يتم الخيار ويقبض ولم يذكر المصنف صحة العبادة وفسادها والسؤال وارد فيها أيضا وقد ذكر المصنف بعد هذا ما هو المعتمد في تفسير الصحة وهو أنها استتباع الغاية ومعناه أن العبادة أو العقد بحيث يترتب عليه أثره وهو الغاية المقصودة منه وغاية البيع مثلا إباحة الانتفاع فإن وقع البيع بحيث يكون كذلك كان صحيحا وإلا كان فاسدا وبهذا يصح تعليل إباحة الانتفاع بالصحة ويندفع توقف الإباحة على الخيار والقبض لأنه قد ينعقد السبب بحيث يترتب عليه مقصوده وإن توقف على شرط إذا وجد ذلك الشرط أضيف المشروط إلى السبب السابق إذا عرفت هذا فكون البيع بحيث يترتب عليه حل الانتفاع حكم ليس اقتضاء ولا تخيير فهو خارج عن الحد ورجوعه إليه بالطريق التي تقدمت في الدلوك وهو أن نقول الصحة نزلت منزلة قول الشارع جعلته مبيحا للانتفاع أي معرفا للإباحة والتخيير المذكور في الحد معناه إباحة الانتفاع عنده وحاصل العبارتين سواء
بقي هنا نظر آخر وهو كون البيع بحيث يترتب عليه حل الانتفاع هل هو معنى شرعي زائد على الإيجاب والقبول وسائر ما يعتبر معه أو هو تلك الأشياء فقط بغير زيادة أو مجموعهما يحصل به ذلك فإن كان الأول وهو المشهور عند الجمهور كان ذلك المعنى حكما شرعيا مفارقا لذات الدلوك مساويا لجعل الدلوك معرفا للوجوب فلذلك تعللت بطلب الطريق للثاني إذ لا يمكن إنكار كون ذلك شرعيا وإن كان الثاني وهو مقتضى كلام بعضهم ساوى الدلوك من كل وجه أمكن أن يقال حينئذ إن معنى الصحة الإعلام بإباحة الانتفاع عند اجتماع تلك الأمور وليست حكما بل إعلاما بالحكم وكذلك إن جعلنا الصحة وقوع البيع أو العبادة على وفق الوجه المشروع وقلنا إن هذا معنى عقلي لا شرعي فيأتي الطريقان أيضا في الجواب
والترديد في أقسام المحدود لا في الحد
هذا جواب عن السؤال الثالث وبيانه أن الترديد المنافي للتحديد هو الترديد في الحد وهنا ليس كذلك لأن الترديد إنما يكون في الحد لو كانت أو داخلة بين الجنس والفصل أو بين الفصول وههنا إنما وقعت بين أقسام الفصل الآخر وذلك أنه لما كان الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين يشمل الاقتضاء والتخيير وغيرهما أتى بالفصل الآخر ليخرج غيرهما ويصير الفصل أحدهما من غير تعيين أعم من كونه اقتضاء أو تخييرا فهذا القدر المطلق هو الفصل ولا ترديد فيه ولكنه ينقسم إلى اقتضاء وتخيير فأتت أو بين قسميه فلا يحصل بها إخلال في الحد والفصل مساو للمحدود وكل ما كان أقساما لشيء كان أقساما لمساويه فلذلك قال المصنف إنها في أقسام المحدود ولم يكن الحد بدون أحدهما مانعا فلذلك لا بد من الفصل بأحدهما مطلقا و أو داخلة بين المعنيين وكل منهما معينا أخص من أحدهما مطلقا ولو وجد عبارة تشملهما أو تخرج غيرهما استراح من هذا السؤال وجوابه وقد خطر لي أن يكون الإنشاء فإنه يخرج الخبر ويشمل الاقتضاء والتخيير فيقال هذا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الإنشاء
ويندرج فيه خطاب الوضع وكون الشيء سببا وشرطا ومانعا والحكم بالصحة والفساد سواء قلنا إن ذلك يرجع بتأويل إلى الاقتضاء والتخيير أم لا ويندرج فيه مثل قوله تعالى زوجناكما فتزويج الله لنبيه زينب حكم شرعي
الفصل الثاني في تقسيماته الأول
الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب وإن لم يمنع فندب وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة وإلا فكراهة وإن خير فإباحةلما فرغ من تعريف الحكم الشرعي شرع في تقسيمه وحذف قوله وهو من وجوه لدلالة الكلام عليه والألف واللام في الخطاب للمعهود السابق في حد الحكم وهذا التقسيم بحسب ذات الحكم والاقتضاء هو الطلب وقابل المصنف الوجود بالترك ولو جعل موضع الوجود الفعل أو موضع الترك العدم لكان أحسن من حيث اللفظ وأما المعنى ففيه تسمح على التقديرين لأن الترك فعل وجودي فلا يكون تقسيما لا للفعل ولا للوجود ولذلك قال غيره المطلوب إما فعل غير كف وإما كف وهذا بحسب حقيقة الفعل عقلا وأهل العرف يقابلون بين الفعل والترك المطلقين والأولى اعتماده في هذا التقسيم وعدم التقييد بكونه كفا وغير كف وقوله فوجوب صوابه فإيجاب فإنه الحكم والوجوب أثره تقول أوجبه الله إيجابا فوجب وجوبا وكذلك قوله حرمه صوابه تحريم ووجه الحصر بين
ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا
لما ذكر الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة في التقسيم المذكور بأن به ماهية كل واحد منها فالإيجاب طلب الفعل المانع من النقيض
والتحريم طلب الترك المانع من النقيض والإباحة هي التخيير بين الفعل والترك ولك أن تجعل مكان المانع من النقيض الجازم في جميع المواضع فهما مترادفان والأفعال التي هي متعلق هذه الأحكام هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح تظهر ماهيتها بذلك أيضا فيقال الواجب المطلوب الفعل طلبا جازما والمندوب المطلوب الفعل طلبا غير جازم والحرام المطلوب الترك طلبا جازما والمكروه المطلوب الترك طلبا غير جازم والمباح المخير فيه ولكنه ذكر لها رسوما أخرى تظهر بها حقائقها وبدأ بالواجب
وترك ذكر الجنس وهو الفعل لدلالة الكلام عليه واكتفى بذكر الخواص فقوله الذي صفة لمحذوف أي الفعل الذي فالفعل جنس يشمل الخمسة والذي يذم تاركه أخرج المندوب والحرام والمكروه والمباح وعادة الأصوليين يقولون الذي يذم يخرج المندوب والمكروه والمباح وتاركه يخرج الحرام وكان الباجي يشرحه كذلك وأنا لا أختار هذا لأن الذي يذم وحده لا يصلح أن يكون فصلا ألا ترى أنك لو قلت الفعل الذي يذم لم بكن جنسا للمحدود ولا مفيدا للمقصود وقوله شرعا احترازا عن مذهب المعتزلة فإن عندهم الذم بالعقل فأشار بهذا إلى قاعدة الأشاعرة وهي أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع وقدم شرعا على تاركه حتى يتبين أن انتصابه عن يذم وقوله قصدا متعلق تاركه وهو قيد ليس في المحصول ولا في الحاصل وأراد به إدخال الواجب إذا ترك سهوا فإنه لا يذم ولا يخرجه ذلك عن الواجب ولو لم يقل ذلك لكان الرسم مطردا وغير منعكس لأن ما لا يذم تاركه قد يكون واجبا بأن يتركه سهوا وإطلاق تاركه مع ما فيه من العموم المستفاد من الإضافة يقتضي أن ما لا يذم كل تارك له ليس بواجب فقيد التارك بالقصد وكل قيد في الفصل يكثر به المحدود بخلاف زيادة الفصول فإنه ينقص بها الحدود وصار الرسم بهذا القيد مطردا منعكسا أما اطراده فلأن كل ما يذم تاركه قصدا ليس بواجب
فإن قلت الساهي غير مكلف فليس الفعل في حقه واجبا فلا يوصف بترك الواجب قلت إما أن يكون بني هذا على رأى الفقهاء فإنهم يقولون الصلاة واجبة على الساهي والنائم ولذلك يجب القضاء عليهما وإما أن يفرض
فيهن سهى عن الصلاة بعد دخول وقتها ووجوبها عليه واستمر سهوه حتى خرج الوقت فالوجوب قد تحقق وتحقق الترك ولا معصية بسبب السهو كمن مات في أثناء الوقت لا يعصى على الصحيح فطريان السهو في أثناء الوقت كطريان الموت وكذا إذا طرأ النوم عن غلبة وإنما قيدت بقولي عن غلبة لأنه إذا قصد النوم حيث يحتمل عنده أن يستيقظ قبل خروج الوقت وألا يستيقظ والاحتمالان على السواء فإنه إذا نام يكون قد عرضها للفوات فيظهر عصيانه وهذا قلته تفقها ثم وجدته في فتاوى أبي عمرو بن الصلاح واستدل بما جاء في الحديث في العشاء أنه نهى عن النوم قبلها وإن غلب على ظنه أو يستيقظ قبل خروج الوقت فالذي يظهر جواز النوم ولا يعصى إذا استغرق به النوم على ندور حتى خرج الوقت ويحمل الحديث على ما سوى هذه الصورة أو على أنه نهى تنزيه وإن ظن أنه لا يستيقظ حرم بلا إشكال مهما نام بعد الوقت أما إذا نام قبله فلا لأن التكليف لم يتعلق به ودع من يعلم من عادته أنه لا يستيقظ إلا بعد الوقت لقول النبي صلى الله عليه و سلم إذا استيقظت فصل فإن قلت هل هذا القيد الذي زاده المصنف لا بد منه حتى يكون الحد بدونه فاسدا قلت ينبني على شيء وهو أن عدم الفعل أعم من تركه فمن مات ونام غلبه أو أقبل الوقت حتى خرج يقال في حقه لم يصل ولا يقال ترك الصلاة ومن اشتغل بضدها وهو ذاكر لها فقد تركها قصدا ومن نام عن اختيار في أثناء الوقت مع علمه من عادته ألا يستيقظ داخل في ذلك وأما الساهي وهو الذي اشتغل بضدها قاصدا لذلك الضد ولم يخطر بباله الصلاة فيقال إنه لم يصل وهل يقال
إنه تارك الصلاة لأجل تلبسه بضدها مختارا له أولا لا يقال ذلك لعدم قصده لها فأشبه من لا ينسب إليه فعل هذا محل نظر فإن أطلقنا عليه اسم التارك فلا بد من القيد المذكور وإلا فلا حاجة إليه وهو الأولى لأن قولنا الواجب ما يذم على تركه معناه على تركه حين كونه واجبا والناس حين نسيانه لم يكن الفعل واجبا عليه فتركه الذي لم يذم عليه والوجوب لم يجتمعا في زمن واحد ولذلك أن القاضي أبو بكر وغيره من الأئمة لم يذكروا هذا القيد
وقوله مطلقا متعلق أيضا بتاركه وهو قيد في الفصل زائد في المحدود كما أشرنا إليه من قبل وأن مقتضاه الإدخال لا الإخراج وقصد به إدخال الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية فإن كلا منها قد يتركه قصدا تركا مقيدا فلا يذم كما إذا ترك الموسع في أول الوقت وفعله في آخره وترك خصلة من خصال المخير وفعل الأخرى وترك فرض الكفاية وقام به غيره لا يأثم في الصور الثلاث وإنما يأثم في الموسع إذا ترك هو لا غيره فإنه يصح حينئذ إطلاق الترك عليه والنوع الرابع من أنواع الواجبات وهو الواجب المضيق إطلاق الترك صادق عليه حيث ترك فلا قيد فشمل كلامه الواجبات الأربعة وهذا القيد وهو قوله مطلقا قاله صاحب الحاصل وحذف قول الأصحاب على بعض الوجوه لأن به يستغنى عنه وهم يجعلون على بعض الوجوه متعلقا بذم وفائدة هذا الرسم أنه إذا لم يرد من الشارع طلب لفعل ولكن ورد ذمه أو ذم فاعله لأجله استدللنا بذلك على وجوبه والذم معروف لغة وعرفا فلا حاجة إلى تفسيره والمعتزلة فسروه بأنه قول أو فعل أو ترك قول أو ترك فعل ينبني على إيضاح حال الفاعل ولأصحابنا معهم مشاححات متكلفة وأورد في المحصول أنه يدخل في هذا التحديد السنة فإن الفقهاء قالوا إن أهل محلة إذا اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإصرار فإنهم يحاربون بالسلاح وهذا الذي قاله في سنة الفجر لم أر من الفقهاء ولا من غيرهم من قاله غيره وإنما قالوه في الأذان والجماعة ونحوهما من الشعائر الظاهرة ومع ذلك الصحيح عندهم إذا قلنا بسنتيها إنهم لا يقاتلون
على تركها خلافا لأبي إسحاق المروزي ويجاب على هذا القول بأن المقاتلة على ما يدل عليه ذلك من الاستهانة بالدين المحرمة لا على ترك السنة
ويرادفه الفرض وقالت الحنيفة الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني
قال أبو زيد الدبوسي من الحنفية الفرض والتقدير والوجوب السقوط فخصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع لأنه الذي يعلم من حاله أن الله قدره علينا والذي عرف وجوبه بدليل ظني نسميه بالواجب لأنه ساقط علينا ولا نسميه بالفرض لأنا لا نعلم أن الله قدره قلنا الفرض المقدر أعم من كونه علما أو ظنا والواجب هو الساقط أعم من كونه علما أو ظنا فتخصيص كل من اللفظين بأحد القسمين تحكم ولو قالوا إن هذا مجرد اصطلاح لم نشاححهم والنزاع في موافقته للأوضاع اللغوية ثم زادوا وادعوا أن الفرض والواجب مختلفان بالحقيقية وقصدهم من هذا أن الوتر واجب وليس بفرض وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة بالحديث وأصل القراءة فرض بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه ولو سلم لهم الاختلاف في الطريق لم
يلزم منه الاختلاف في الحقيقة ثم لم يستمروا على ذلك وجعلوا القعدة في الصلاة فرضا ومسح ربع الرأس فرضا ولم يثبتا بقاطع
وقد جاء في الحديث فريضة الصدقة يعني النصب والمقادير ويلزم الحنفية ألا يكون شيء من ذلك فرضا وألزمهم القاضي ألا يكون شيء مما ثبت وجوبه بالسنة كنية الصلاة ودية الأصابع والعاقلة فرضا وأن يكون الاشهاد عند السامع ونحوه من المندوبات الثابتة بالقرآن فرضا لما ادعوا أن الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة
والمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه لك أن تجعل ما بمعنى الذي كما قال في الواجب وأن تجعلها نكرة أي فعل وهو جنس للخمسة ويحمد فاعله خرج به المباح والحرام والمكروه ولا يذم تاركه خرج به الواجب والعموم المستفاد من النفي في قوله ولا يذم تاركه أغنى عن التقييد بقوله قصدا مطلقا وفي بعض النسخ يمدح مكان يحمد وقد تقدم الكلام في الخطبة على الحمد والمدح ولا بد من قوله شرعا وكأنه لما ذكرها في حد الواجب اكتفى به عن ذكرها في الأربعة مع إرادتها وظن شيخنا الجزري أن الناسخ أسقطها فلحقها بالأصل
ويسمى سنة ونافلة من أسمائه أيضا أنه مرغب فيه وتطوع ومستحب والترادف في هذه الأسماء عند أكثر الشافعية وجمهور الأصوليين
وقال القاضي حسين من الشافعية السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم والمستحب ما فعله مرة أو مرتين والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يردد فيه نقل وقالت المالكية السنة ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم على فعله مظهرا له والنافلة عندهم وله رتبة من الفضيلة التي هي أنزل رتبة من السنة وللحنفية اصطلاح آخر في الفرق بين السنة والمستحب والصحيح ما قدمناه أولا لقوله صلى الله عليه و سلم من سن سنة ولقوله ولكن أنسى لأسن فانظر
كيف جعل السنة بما يحصل نسيانا وهو أندر شيء يكون وأما المندوب فلا شك في عمومه لجميع ما ذكر والأصل المندوب إليه ولكنه حذف إليه وتوسع فيه فقبل المندوب وفي السنة اصطلاح وهو ما علم وجوبه أو ندبيته بيته بأمر النبي صلى الله عليه و سلم
والحرام ما يذم شرعا فاعله فبقوله يذم فاعله خرجت الأربعة وكان ينبغي للمصنف على طريقته أن يقول قصدا لأن وطء الشبهة يصفه بعض الفقهاء بالتحريم ولا يذم عليه الصواب حذفها من الموضعين وأما قوله في الواجب مطلقا فلإدخال الواجب المخير والموسع وفرض الكفاية وليس ذلك في الحرام إلا أن الآمدي نقل خلافا في الحرام المخير فأصحابنا أثبتوه في نكاح الأختين والمعتزلة نفوه وكان الباجي يقول الحق نفيه لأن المحرم الجمع بينهما كما نطق به القرآن لا إحداهما ولا كل واحدة منهما بخلاف الواجب المخير فإن الواجب إما أحدهما وإما كل منهما على التخيير فلذلك الذي قال على بعض الوجوه في الواجب لم يذكرها في الحرام ولم يحتج المصنف إلى زيادة قيد آخر وأنا أقول في الأختين كذلك إن الحرام الجمع فقط وأثبت الحرام المخير كما أثبته القاضي أبو بكر وغيره من الأشعرية وأمثله بما إذا أعتق إحدى أمتيه فإنه يجوز له وطء إحداهما ويكون الوطء تعيينا للعتق في الأخرى وكذا إذا طلق إحدى امرأتيه وقلنا الوطء تعيين على أحد القولين ففي هذين المثالين الحرام واحدة لا بعينها
وقسم القاضي الأفعال إلى متماثلة ومختلفة فالمتماثلة لا يتعلق الأمر باثنين مبهما ولا جمعا بلا تخيير كاللونين في مكان واحد لعدم غيرهما والمختلفان كاللون والكلام يصح الأمر والنهي عنهما جمعا وتخييرا والضدان يجوز النهي تخييرا والنهي عنهما جميعا ولا يصح الأمر بهما جميعا وصورة التحريم المخير صريحا يقول حرمت هذا أو هذا وكذا لو قال لا تفعل كذا أو لا تفعل كذا فإن قال لا تفعل أو تفعل كذا بإسقاط أو كذا أو قال لا تفعل كذا أو كذا احتمل النهي المخير والنهي عن كل منهما وهو في الثاني أظهر وعلى ذلك قوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا وقريب من هذا في المأخذ وإن اختلفا في الصورة قولك ما ضربت زيدا أو عمرا محتمل فإن قلت ولا عمرا كان نصا في أنه لم يضرب واحدا منهما وعند عدمها لا نص ولا ظهور في ذلك
والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله فبقوله يمدح خرج الواجب والمندوب والمباح وبقوله ولا يذم فاعله خرج الحرام وليس معنى المكروه أن الله لم يرد فعله وإنما معناه ما ذكرناه وليس هو حسنا ولا قبيحا وفي المكروه ثلاثة اصطلاحات
أحدها الحرام فيقول الشافعي أكره كذا وكذا ويريد التحريم وهو غالب إطلاق المتقدمين تحرزا عن قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فكرهوا لفظ التحريم
الثاني ما نهى عنه نعي تنزيه وهو المقصود هنا
الثالث ترك الأولى كترك صلاة الضحى لكثرة الفضل في فعلها والفرق بين هذا والذي قبله ورود النهي المقصود والضابط ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه وما لم يرد فيه نهي مقصود يقال ترك الأولى ولا يقال مكروه وقولنا مقصود احتراز من النهي التزاما فإن الأمر بالشيء ليس إلا نهيا عن ضده التزاما فالأولى مأمور به وتركه منهي عنه التزاما لا مقصودا
والمباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم لا بد من الإتيان بلا بين الفعل والترك وبين المدح والذم وبذلك تخرج الأحكام الأربعة فإن الواجب يتعلق بفعل مدح وبتركه ذم والحرام عكسه والمندوب يتعلق بفعله مدح ولا ذم في تركه والمكروه يتعلق بتركه مدح ولا ذم في فعله هذا تمام الرسوم وفيها زيادة على ما اقتضاه التقسيم من تعريف حقائقها وهي فائدة جليلة كما إذا رأينا فعلا لم يرد في الشرع في فعله مدح ولا ذم ولا في تركه أو ورد مدح أو ذم فيحكم بمقتضى ذلك وإن لم تأت صيغة طلب ولا تخيير وقد تقدم التنبيه على أنه لا بد من التقييد في الشرع في الكل وقد تعرض له الإمام في المندوب وصاحب الكتاب تعرض له في الواجب والحرام لأن الذم فيهما وكما أن الذم الذي ثبوته علامة الواجب والحرام هو الذم الشرعي وهو أخص من انتفاء الذم مطلقا فبدون هذا القيد يكون الرسم غير جامع لخروج المباحات التي انتفى الذم الشرعي فيها ووجد فيها ذم عقلي أو عرفي وأعني بالتقييد أن يكون كل من الوصفين المذكورين في طرفي الأحكام الثلاثة ثابتا بالشرع والتنبيه لذلك في قول المصنف المباح ما لا يتعلق بفعله وبتركه مدح ولا ذم إن أراد به عرف من الشرع انتفاء ذلك فصحيح وإن أراد أنه لم يوجد في الشرع مدح ولا ذم كذلك فلا يلزم كونه مباحا فقد يكون باقيا على حكم الأشياء قبل ورود الشرع ولذلك قال الإمام المباح ما علم فاعله أنه لا حرج في فعله ولا في تركه ولا نفع في الآخرة وقول الإمام هذا احتراز عن فعل البهيمة وغير المكلف فلا يكفي في الإباحة عدم الحكم بذلك بل الحكم بعدمه ويحتاج في المندوب والمكروه أن يأتي بقوله شرعا في طرفي الفعل والترك جميعا وتصحيح كلام المصنف أن يحمل على أنه أراد ذلك فإنه محتمل له على أني أقول إن ما لم يوجد في الشرع دليل على مدح ولا ذم في فعله ولا في تركه مباح بأدلة شرعية وإنما أورد عليه فعل غير المكلف كالساهي والنائم والبهائم وطريق الاعتذار عنه ما ذكرته أو يقال إنه إنما يتكلم في فعل المكلف
التقسيم الثاني للحكم باعتبار الحسن والقبيح
الثاني ما نهى عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلفالحكم ينقسم بذاته إلى التحسين والتقبيح وتنقسم صفة الفعل الذي هو متعلقه إلى الحسن والقبيح ويتبع ذلك انقسام اسمه إلى حسن وقبيح فلذلك قسم الفعل إلى ما نهى عنه شرعا وهو القبيح وما لم ينه عنه شرعا وهو الحسن ومنه يعرف الحسن والقبيح والتحسين والتقبيح وإطلاق الحسن على الواجب والمندوب لا شك فيه وعلى المباح فيه خلاف والأصح إطلاقه عليه للإذن فيه والجواز الثناء على فاعله وإن لم يؤمر بالثناء عليه وفعل الله تعالى حسن باتفاق من به يعتمد لوجوب الثناء عليه وفعل ما سواه من غير المكلف كالنائم والساهي والبهيمة فيه خلاف مرتب على الخلاف في المباح وأولى بالمنع وهو الذي اختاره إمام الحرمين ولا شك في عدم إطلاق القبح في المباح وفعل غير المكلف فإذا أخرجناهما عن قسم الحسن كانا واسطة بين الحسن والقبح وأما المكروه فقال إمام الحرمين إنه ليس بحسن ولا قبيح فإن القبيح ما يذم عليه وهو لا يذم عليه والحسن ما يسوغ الثناء عليه وهذا لا يسوغ الثناء عليه ولم أر أحدا يعتمد خالف إمام الحرمين فيما قال إلا ناسا أدركناهم قالوا إنه قبيح لأنه منهى عنه والنهي أعم من نهي تحريم وتنزيه وعبارة المصنف بإطلاقها
تقتضي ذلك وليس أخذ الحكم المذكور من هذا الإطلاق بأولى من رد هذا الإطلاق بقول إمام الحرمين
فإن قلت إدراج المصنف وغيره لفعل غير المكلف لا يتعلق به الحكم لأن الحكم هو المتعلق بأفعال المكلفين قلت الفعل الذي هو متعلق الحكم والفعل الحسن بينهما عموم وخصوص من وجه فقسمنا الأول إلى حسن وغيره والحسن من هذه القسمة لا يشمل فعل غير المكلف ثم قسمنا مسمى الحسن مطلقا إلى فعل المكلف وغيره مما ليس متعلقا بالحكم فخرج من التقسيمين أن الواجب والمندوب والمباح من قسم الحسن المحكوم فيه وأن فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم فيه وهذا شأن العام من وجه حيث وقع وإنما يلزم أن يكون المقسم إلى المقسم إلى الشيء صادقا على ذلك الشيء مطلقا إذا كان التقسيم في الأعم والأخص مطلقا
والمعتزلة قالوا ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله وما له أن يفعله وربما قالوا الواقع على صفة توجب الذم والمدح فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص
يعني أن المعتزلة قالوا إن القبيح ما ليس للقادر عليه للعالم بحاله أن يفعله والحسن ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله هذا تفسيرهم الأول والإمام نقله عن أبي الحسين واعترض عليه بأن قولك ليس له أن تفعله تقال للعاجز عن الفعل للقادر عليه إذا منع منه وإذا كان شديد النفرة وإذا زجره الشرع عنه والأولان غير مرادين ولا الثالث لأن الفعل قد يكون حسنا مع النفرة الطبيعية عنه والرابع يصير القبيح مفسرا بالمنع الشرعي يعني وهو قولنا وأنتم لا تقولون به فصار الحد غير كاشف عن مرادكم وأصل هذا أن صفة الحسن والقبح عندهم بالعقل وعندنا بالشرع فلا بد لهم من بيانها وذكر الإمام تفسيرهم الأخير أيضا عن أبي الحسين واعترض عليه بأنه يجب تفسير الاستحقاق فقد
يقال الأثر يستحق المؤثر أي يفتقر إليه لذاته والمالك يستحق الانتفاع بملكه أي يحسن منه والأول ظاهر الفساد والثاني يقتضي تفسير الاستحقاق بالحسن مع أنه فسر الحسن بالاستحقاق حيث قال الحسن هو الذي لا يستحق فاعله الذم فيلزم الدور فإن أراد معنى ثالثا فليبينه ثم نازعهم في تفسير الذم قال وهذه الإشكالات غير واردة على قولنا والمصنف أخذ معنى الحد الثاني دون لفظه ومراده أن القبيح هو الواقع على صفة توجب الذم والحسن هو الواقع على صفة توجب المدح وفي بعض نسخ المنهاج فالحسن بتفسيرهم أخص وفي بعضها فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص وكلاهما صحيح فإن الحسن بتفسيرهم الأخير أخص منه بتفسيرهم الأول لدخول المباح في الأول دون الأخير والحسن بتفسيرهم أخص منه بتفسيرنا لدخول فعل غير المكلف في تفسيرنا دون تفسيرهم ولم يتعرض للقبيح ما حاله على التفسيرين ولا شك أنه بالتفسير الأخير لا يقع على غير الحرام وبتفسيرهم الأول هل يختص به فيستوي على التفسيرين أو يقع عليه وعلى المكروه فيكون بتفسيرهم الأخير أخص كالحسن فيه احتمال والأقرب الأول وقد نقل إمام الحرمين عن بعض المعتزلة أنه ارتكب إطلاق القبيح على فعل البهيمة وهذا يخالف التفسيرين ولعله يرتكب ذلك في الحسن
التقسيم الثالث للحكم إلى السبب والمسبب
الثالث قيل الحكم إما سبب وإما مسبب كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على الزاني فإن أريد بالسببية الإعلام فحق وتسميتها حكما بحث لفظي وإن أريد التأثير فباطل لأن الحادث لا يؤثر في القديم ولأنه مبني على أن للفعل توجب الحسن والقبح وهو باطلهذا تقسيم آخر للحكم باعتبار أنه كما يكون بالاقتضاء أو التخيير يكون بالوضع كجعل الزنا سببا وقد تقدم الكلام في هذا في تعريف الحكم وهذا التقسيم منسوب إلى الأشعرية وهو مطرد في كل حكم عرفت علته فلله فيه حكمان
أحدهما الحكم بالسببية واختلف الناس في جواز القياس
والثاني الحكم بالمسبب والقياس عليه جائز باتفاق القايسين واتفق الأشعرية على أنه ليس المراد من الأول كون السبب موجبا للحكم لذاته أو لصفة ذاتية بل المراد منه إما المعرف وعليه الأكثرون وإما الموجب لا لذاته أو لصفة ذاتية ولكن يجعل الشرع إياه موجبا وهو اختيار الغزالي والإمام وافق الأكثرين معنى وخالفهم لفظا وخالف العزالي معنى ولفظا وإلى موفقة الأكثرين في المعنى دون اللفظ أشار المصنف بقوله فإن أريد بالسببية الإعلام فحق وتسميتها حكما بحث لفظي وإلى مخالفة الغزالي لفظا ومعنى أشار ببقية كلامه فإن الإمام زيف كلام الغزالي من ثلاثة أوجه
أحدها أن الزنا حادث والإيجاب قديم والحادث لا يؤثر في القديم
الثاني أن الزنا قبل الجعل لم يكن مؤثرا فإن بقي بعد الجعل كما كان وجب ألا يصير مؤثرا وإن لم يبق كان إعداما لتلك الحقيقة والشيء بعد عدمه لا يكون مؤثرا
الثالث أنه لو جعل الزنا علة فالصادر بعد الجعل إما الحكم فالمؤثر في الحكم هو الشارع فلم يكن الزنا مؤثرا وإما شيء يوجب الحكم فيكون المؤثر في الحكم وصفا حقيقيا وهو قول المعتزلة في الحسن والقبح وهو باطل وإن لم يكن الحكم ولا ما يوجبه فهو محال لأن الشرع لما أثر في شيء غير الحكم وغير مستلزم للحكم لم يكن لذلك الشيء تعلق بالحكم أصلا والمصنف اقتصر على الأول وأخذ أقسام الثالث لأنها صفوة الكلام قال سراج الدين ولقائل أن يقول على الأول لعلهم أرادوا جعل الزنا سببا لتعلق الحكم به وعلى الثاني أنه يجوز بقاء الحقيقة مع طريان صفة المؤثرية به وعلى الثالث أن الصادر من الشارع وهي غيرهما ولهما تعلق بالحكم ولك أن تقول على الأول إن التعلق قديم فالسؤال بحاله وعلى الثاني إن المؤثرية نسبة والمؤثر لا بد أن يشتمل على صفة حقيقية لأجلها يصدر الأثر عنه والمؤثرية بدون ذلك محال وعلى الثالث أن المؤثرية بدون صفة حقيقية محال لما سبق ومعها يوافق قول المعتزلة وكلام الإمام يرشد إلى هذا فإنه قال إن كان الصادر ما يوجب الحكم كان المؤثر في الحكم وصفا حقيقيا فدخل في قوله ما يوجب الحكم المؤثر والمؤثرية ولذلك لم يقل كان وصفا حقيقيا بل قال كان المؤثر في الحكم فأخذ الإمام على التقديرين وقال إنه هل يعقل تأثير من غير أن يكون المؤثر مؤثرا بذاته أو بصفة قائمة أو لا يعقل ذلك وعلى هذا ينبني كون العبد موجدا لفعل نفسه باقدار الله تعالى له وخلقه له ما يقتضي تأثيره في الفعل من غير أن يكون العبد مؤثرا بذاته وبصفة ذاتية فأصحابنا ينكرون ذلك ويقولون
الصادر عنه فعل الله والمعتزلة لا يتحاشون من القول بتأثيره بذاته أو بصفة وشذوذ منا توسطوا فقالوا بمثل ما قالوا به هنا في الحكم بالسببية ويلزمهم ما لزم هذا ما يتعلق بكلام الإمام وأما المصنف وقوله أنه ينبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح فيحتاج إلى مقدمة وهي أن المعتزلة مع إجماعهم على القول بالحسن والقبح العقليين افترقوا فطائفة منهم قالوا إن الفعل لذاته يكون حسنا أو قبيحا من غير صفة وطائفة قالوا بصفة وطائفة قالوا بوجوه واعتبارات وهو الذي أشار إليه المصنف ويلزم من بطلان قولهم في ذلك بطلان قولهم في الصفة وفي الذات من طريق الأولى فما سلكه أتم في الزام مذهب المعتزلة مما سلكه الإمام في الصفة لأنه قد لا يوافق قائل هذه المقالة المعتزلة في الذات والصفة الحقيقية ويوافقهم في الوجوه والاعتبارات فإذا بين بطلان قولهم فيه بطل قوله والمراد بالوجوه أن الوطء مثلا له جهة نكاح وجهة زنا فيحسن بالأولى ويقبح بالثانية
التقسيم الرابع للحكم باعتبار الصحة والفساد
الرابع الصحة استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد وغاية العبادة موافقة الأمر عند المكلمين وسقوط القضاء عند الفقهاء فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة على الأول لا الثانيتفسير الصحة باستتباع الغاية جيد من جهة كونه شاملا للعبادات والمعاملات إلا أن الأولى في تحرير العبارة أن يقال كون ذلك الشيء يستتبع غايته فإن استتباع الغاية يقتضي حصول التبعية وقد يتوقف ذلك على شرط كالعقد في زمن الخيار وكونه يستتبع الغاية صحيح وإن توقفت التبعية على شرط لأن معناه أنه بهذه الحيثية وتفسير المتكلمين جيد لأن الصحة في اللغة مقابلة للمرض وعلى هذا النحو ينبغي أن يكون في الاصطلاح فما وافق الأمر لا خلل فيه فيسمى صحيحا وجب قضاؤه أم لم يجب وما لم يوافق الأمر فيه خلل فيسمى فاسدا والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء على من صلى ظانا الطهارة فتبين حدثه إذا كانت الصلاة فريضة وتسمية الفقهاء إياها فاسدة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة كما ظنه الأصوليون بل لأن شرط الصلاة الطهارة في نفس الأمر والصلاة بدون شرطها فاسدة ولا مأمور بها بل هو ظن أنه متطهر فترتب عليه الحكم بمقتضى ظنه وأمره ظاهرا بها كأمر المجتهد المخطئ بما ظنه وغايته أنه سقط عنه الإثم وأما أنه أتى بالمأمور به فلا وقولهم إن المامور به صلاة على مقتضى ظنه فممنوع بل صلاة على شروطها في نفس الأمر ويسقط عنه الإثم بظنه وجودها وقد رأينا الفقهاء قيدوا فقالوا كل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به وهذا التقييد يقتضي انقسام الصحة إلى ما
يغني عن القضاء وما لا يغني وقالوا فيمن لم يجد ماء ولا ترابا إنه يصلي على حسب حاله ويقضي وحكى إمام الحرمين في هذه الصلاة هل توصف بالصحة أو الفساد وجهين وهو غريب والمشهور وصفها بالصحة وكيف نأمره بالإقدام على صلاة يحكم بفسادها هذا لا عهد به وليس بمثابة الإمساك تشبها بالصائمين
والفرق بين هذه الصلاة وصلاة من ظن الطهارة أن هذا عالم بحاله والظان جاهل فالعالم أتى بجميع ما كلف به الآن وبقي شرط أسقط عنه لعجزه ووجب استدراكه بعد ذلك بالقضاء والظان لم يأت بما هو الآن فريضة فالصواب أن يكون حد الصحة عند الفريقين موافقة الأمر غير أن الفقهاء يقولون ظان الطهارة مأمور بها مرفوع عنه الإثم بتركها والمتكلمون يقولون ليس مأمورا فلذلك يكون صلاته صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء ومن أمرناه بصلاة بلا طهارة ولا تيمم حيث يجب القضاء صحيحة على المذهبين وإن أوجب القضاء فليس كل صحيح يسقط
واقتصر المصنف على غاية العبادة لذكر الخلاف ولم يذكر غاية العقود والمراد من كون العقد صحيحا عند المتكلمين على ما اقتضاه كلام القاضي أبي بكر وقوعه على وجه يوافق حكم الشرع من الإطلاق له وعند الفقهاء كونه بحبث يترتب أثره عليه وهو معنى إطلاقهم ترتب أثره
والباطل هو الذي لا يترتب أثره عليه والبطلان والفساد لفظان مترادفان والإزاء والحذاء والمقابل ألفاظ مترادفة وجعل المصنف هذا تقسيما رابعا للحكم يقتضي أن الصحة والبطلان حكمان شرعيان ويكون الحكم تارة بالصحة وتارة بالبطلان وقد تقدم الكلام في رده إلى الاقتضاء والتخيير أو في كونه زائدا عليه وخالف ابن الحاجب الجمهور فقال إن الصحة والبطلان
أو الحكم بهام أمر عقلي وقال في المنتهى القول بأن الحكم بالصحة والبطلان حكم شرعي بعيد وحجته أن الموافقة أمر عقلي وقد فسرنا الصحة بها وأورد عليه أن العقلي ما لا مدخل للشرع فيه وهذا للشرع فيه مدخل فتسميته شرعيا غير بعيد وفهم بعض من شرح كتابه أنه لا يطرد قوله في صحة العقود لأن ترتب الأثر شرعي ولا يبعد طرده لأن الصحة ليست ترتب الأثر بل كونه بحيث يترتب الأثر عليه ومعنى ذلك وقوعه على وجه مخصوص وذلك أمر عقلي لكن تسميته شرعيا باعتبار أن للشرع مدخلا كما قلنا في العبادات
وأعلم أن الإمام وأتباعه ومنهم المصنف أنكروا كون الصحة حكما زائدا على الاقتضاء والتخيير وأنكروا الحكم بالسببية كما سبق في الموضعين فلم يبق للصحة معنى عندهم في العقود إلا إباحة الانتفاع وهو شرعي ومن يفسر الصحة بكونه مبيحا للانتفاع يلزمه أن يوافق الغزالي في الحكم بالسببية أو يقول إنها عقلية وحكم القاضي مثلا بصحة عقد إنما يصح إذا قصد المعنى الشرعي لأنه الذي يثبته القاضي بخلاف الأمر العقلي وليس للقاضي أن يحكم إلا بما يصح أن يكون حكما من الشارع من اقتضاء أو تخيير أو خطاب وضع إن قلنا به وإذا جعلت الصحة عقلية لم يكن للقاضي الحكم بها بل بأثر الصحيح
وأبو حنيفة ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا وما شرع بأصله دون وصفه كالزنا فاسدا
عند الحنفية إن كان العوضان غير قابلين للبيع كبيع الملاقيح بالدم مثلا فهو باطل قطعا وكذا إن كان المبيع وحده كبيع الملاقيح بالدراهم على الصحيح عندهم وإن كانا قابلين للبيع ولكن جاء الخلل من أمر آخر كبيع درهم بدرهمين كل من العوضين قابل للبيع والخلل من الزيادة فهو فاسد قطعا وكذا إن كان الثمن فقط كبيع ثوب بدم على الصحيح عندهم والفاسد عندهم إذا اتصل بالقبض يفيد الملك الخبيث والباطل لا يفيد شيئا وعندنا الباطل والفاسد سواء في المعنى والحكم ولا يفيد شيء منهما الملك
والملاقيح ما في بطون الأمهات وقد علمت المراد بأصله وهو كون المبيع يصح بيعه ووصفه هو الصحيح
وأما فرق أصحابنا بين الباطل والفاسد في الكتابة فلا يضرنا في نصب الخلاف في البيع ومحل الرد عليهم في ذلك كتب الفقه وكتب الخلاف
تعريف الأجزاء
والأجزاء هو الأداء الكافي التعبد به وقيل سقوط القضاء ورد بأن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب فكيف سقط فإنكم تعللون سقوط القضاء به والعلة غير المعلوللما كان الإجزاء معناه قريب من معنى الصحة ذكره معها ولم يفرده بتقسيم ولكن الصحة أعم فإنها تطلق على المعاملات ولا يطلق الإجزاء في المعاملات
وقوله الأداء يجب حمله على الأداء اللغوي لأن الإجزاء كما يكون في الأداء يكون في القضاء والإعادة فلو قال الفعل كان أحسن والضمير في به يعود على الأداء وما أورده من أن القضاء إذا لم يجب لا يقال سقط صحيح وهو وارد من حد الصحة بسقوط القضاء أيضا وما أورده من تعليل سقوط القضاء بالإجزاء تبع فيه الحاصل وعبارة المحصول لأنا نعلل وجوب القضاء بأن الفعل الأول لم يكن مجزئا والعلة مغايرة للمعلول فظن بعض الناس أنه انقلب على الإمام وكان الباجي يقول إنها إحدى عقد المحصول ويحتج بحلها زاعما أنه لو ادعى تعليل سقوط القضاء بالإجزاء منعه الخصم وقال هذا عين النزاع فأخذ مقابلها وأثبت التغاير بينهما وهو خارج عن محل النزاع ثم ينقل التغاير إلى محل النزاع لثبوت تغاير المقابلين ومن ضرورة ذلك تغاير مقابليهما و وأيا ما كان فقد أورد عليه أن العلة قد تكون لشيء وقد تكون لحكمنا كما إذا قلت هذا إنسان وسئلت لم حكمت عليه بذلك فتقول لأنه حيوان ناطق فالمغايرة هنا بين العلة وحكمك لا بينها وبين المحكوم به وهذا الإجزاء عن لحكمنا بسقوط القضاء لا لسقوط القضاء نفسه وليس هذا بالقوى
في المحصول إيراد ثالث وهو أنه لو أتى بالفعل عند اختلال بعض
شرائطه ثم مات لم يكن الفعل مجزئا مع سقوط القضاء ولك أن تمنع سقوط القضاء هنا بل يبقى في ذمته إن كان مفرطا
وقول المصنف لعدم الموجب يعني أن القضاء إنما يجب بأمر جديد بعد خروج الوقت إذا ترك ولم يوجد
وإنما يوصف به وبعدمه ما يحتمل وجهين كالصلاة لا المعرفة ورد الوديعة
الصلاة تقع تارة على وجه يكفي في سقوط التعبد بها وتارة على وجه لا يكفي فوصفت بالأجزاء وبعدمه لاحتمالها للوجهين المذكورين وأما المعرفة فلا يقال فيها مجزئة وغير مجزئة لأنه إن تعلق العلم بالله تعالى فهو المعرفة وإلا فلا معرفة بل الجهل وكذلك رد الوديعة والمغصوب إن حصل إلى المالك أو وكيله برئ وإلا فلا رد وقال الأصفهاني في شرح المحصول إنه لا يقال في العبادة المندوب إليها إنها مجزئة أو غير مجزئة وهذا الذي قاله بعيد وكلام الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض وقد ورد في الحديث أربع لا تجزئ في الأضاحي واستدل به من قال بوجوب الأضحية وأنكر عليه
وفي حديث أبي بردة يجزئ عنك ضبطه ابن الأثير بالوجهين بضم الياء مع الهمزة وفتحها مع الياء يقال أجزأ بمعنى كفى وجزا بمعنى قضى ولا توصف المعاملات بالأجزاء وإنما يوصف به ما كان مأمورا به فالصحة أعم محلا منه لأنها تكون في المعاملات والعبادات ولا يوصف بها أيضا إلا ما يحتمل وجهين أن يقع صحيحا وفاسدا كالصلاة والعقود فإنها إن وقعت مستجمعة الأركان والشروط كانت صحيحة وإن وقعت على غير ذلك الوجه كانت فاسدة بخلاف المعرفة ليس لها إلا وجه واحد وهو إذا جعلنا اسم الصلاة موضوعا للصحيح والفساد ظاهر وأما إذا قلنا هو موضوع للصحيح فقط ولا يطلق على الفاسد إلا مجازا فإنه لا يكون لها إلا وجه واحد فكأنهم نظروا إلى المعنى الأعم الموجب للإطلاق المجازي وجعلوه مورد التقسيم إلى الصحيح وغيره ولا يرد هذا السؤال في الإجزاء لإنقسام الصحيح إلى مجزئ وغير مجزئ كصلاة المتيمم في الحضر ونحوه
وعند أبي حنيفة كل صلاة وجب قضاؤها لا يجب أداؤها وكل صلاة يجب أداؤها لا يجب قضاؤها فيستوي عنده الصحة والإجزاء فيكون انقسام العبادة إليها بالإعتبار الآخر
التقسيم الخامس للحكم إلى الأداء والإعادة والقضاء
الخامس العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل وإلا فإعادة وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء وجب أداؤه كالظهر المتروكة قصدا أو لم يجب وأمكن كصوم المسافر والمريض أو امتنع عقلا كصلاة النائم أو شرعا كصوم الحائضهذا تقسيم آخر للعبادة التي هي متعلق الحكم ويصح جعله تقسيما للحكم من جهة أن الأمر قد يكون بالإعادة
وقوله العبادة يشمل الفرض والنفل فكل منهما إذا كان مؤقتا يوصف بالثلاثة وزعم بعضهم أنه لم يوصف بشيء من الثلاثة إلا الواجب وزعم بعضهم أن القضاء لا يوصف به إلا الواجب وكل ذلك خطأ والصواب أن الواجب والمندوب كل منهما يوصف بالأداء والإعادة والقضاء
وقوله إن وقعت لو قال إن أوقعت كان أحسن لأن الأداء والإعادة والقضاء أنواع للإيقاع لا للوقوع لكن لك أن تنتصر لتصحيح كلامه بأن العبادة فعل الفاعل ففعلها وإيقاعها وأداؤها ووقوعها سواء
وقوله في وقتها المعين الأحسن عندي في تفسيره أنه الزمان المنصوص عليه لفعلها من جهة الشرع فإن المأمور به تارة يعين الأمر وقته كالصلوات الخمس وتوابعها وصيام رمضان وزكاة الفطر فإن جميع ذلك قصد فيه زمان معين وتارة يطلب الفعل من غير تعرض للزمان وإن كان الأمر يدل على الزمان بالالتزام ومن ضرورة الفعل وقوعه في زمان ولكنه ليس مقصودا للشارع ولا مأمورا به قصدا فالقسم الأول يسمى مؤقتا والقسم الثاني يسمى غير مؤقت وسواء قلنا في القسم الثاني إن الأمر يقتضي الفور والتراخي أو كان قد
دل على ذلك قرينة كإنقاذ الغريق ونحو ذلك وإلا فإن المقصود من هذا كله إنما هو الفعل من غير تعرض إلى الزمان والقسم الأول قصد فيه الفعل والزمان إما لمصلحة اقتضت تعيين ذلك الزمان وإما تعبدا محضا والقسم الثاني ليس فيه إلا قصد الفعل فالقسم الثاني لا يوصف فعله بأداء ولا قضاء لأنهما فرعا الوقت ولا وقت له وينبغي أن يوصف بالإعادة إذا تقدم فعل مثله على ما سأبينه
ومن هذا القسم الإيمان فإنه لا وقت له والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان وقته وقت سببه ولكنه ليس وقتا معينا من حيث هو وإنما هو حضوره وكذا زكاة المال إذا حال الحول كل هذه واجبات فورية غير مؤقتة وكذا الواجبات على التراخي بلا حد وقد أطلق الفقهاء على الحج الأداء متى أوقع حجة الإسلام في عمره والقضاء في صورتين
احداهما إذا قضي عنه بعد موته
والثانية إذا حج العبد وأفسد حجه ثم عتق فحج عن حجة الإسلام ثم عن القضاء
وعندي أن إطلاقهم الأداء والقضاء في ذلك بطريق المجاز فإن الحج من القسم الثاني الذي لم يقصد فيه غير الفعل وإن وسع فيه مدة العمر عندنا أو ضيق وجب فيه الفور عند غيرنا فإن ذلك لا يصير الوقت مقصودا فيه وأما إذا أفسد حجة الإسلام وأمرناه بقضائها فقد صرحوا أن ذلك ليس بقضاء يعنون بل هو أداء معاد
وإذا عرفت هذا فلنتكلم في مقصودنا وهو القسم الأول مؤقت بوقت معين سواء كان مضيقا كصوم رمضان أو موسعا كالصلاة فإن فعل في وقته فهو أداء سواء فعله مرة أخرى قبل ذلك أم لا هذا هو الذي تختاره وهو مقتضى إطلاقات الفقهاء ومقتضى كلام الأصوليين القاضي أبي بكر في التقريب والإرشاد والغزالي في المستصفى والإمام في المحصول ولكن الإمام لما أطلق ذلك ثم قال إنه إن فعل ذلك ثانيا بعد ذلك سمي إعادة ظن صاحبا الحاصل والتحصيل أن هذا مخصص للإطلاق المتقدم فقيداه وتبعهما
المصنف فإنه كثيرا ما يتبع الحاصل وليس لهم مساعد من اطلاقات الفقهاء ولامن كلام الأصوليين فالصواب أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا مسبوقا كان أو سابقا أو منفردا وقد قال القاضي حسين من الشافعية إنه إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها ثم صلاها في وقتها كانت قضاء وتبعه غيره على ذلك ومأخذه في ذلك أنه لما شرع فيها تعين ذلك الوقت لها حتى لا يجوز له الخروج منها ولم يبق لها وقت شروع وإنما بقي وقت استدامة فإذا أفسدها أو فسدت وقد فات وقت الشروع لم يكن فعلها بعد ذلك إلا قضاء لأن وقت الاستدامة وحده لا يكفي ولا يكون إلا مبنيا على وقت الشروع كما أن المغرب عند العراقيين من أصحابنا لها وقت ابتداء بقدر ما يشرع فيها ووقت استدامة فإذا أخرها مقدار الشروع صارت قضاء عندهم وإن بقي قدر ركعتين وشيء
هذا مأخذ القاضي حسين ومع ذلك هو مردود بوجهين
أحدهما على رأي الإمام والغزالي أعني قولهما إنه يجوز الخروج من الفريضة إذا أمكن تداركها في الوقت فلا يصح ما احتج به له
والثاني أن تعين ذلك الوقت بالشروع بفعله لا بأمر الشرع له أن يفعله وبهذا فارقت المغرب وبما ذكرناه من مأخذ القاضي حسين يعلم أنه ليس مخالفا لما ذكرنا في حد الأداء فإنه إنما قال بالقضاء وعدم الأداء لظنه أن الوقت قد خرج فلا مخالفة في المصطلح وإذا قلنا بقول القاضي حسين فلو دخل في الجمعة ثم أفسدها وأراد إعادتها في الوقت فعلى مقتضى قول القاضي يكون قضاء فإن قال بأنه يعيدها جمعة وهو الذي يظهر فيدخل القضاء في جمعة ولم أر أحدا من الأصحاب تعرض له وإن قال أنه يعيدها ظهرا فبعيد لأن وقت الجمعة على الجملة باق
وقول المصنف وإلا فإعادة أي وإن سبقت بأداء مختلف فإعادة ومراده بالمختل ما فقد ركنا أو شرطا هكذا صرح القاضي أبو بكر فمعنى المختل الفاسد فالإعادة على قول المصنف في الوقت فعل مثل ما مضى فاسدا وقد يورد على هذا بأن الثاني صحيح فليس مثلا للفاسد ويجاب بأنهما اشتركا في الحقيقة الموصوفة بالصحة والفساد وجعل اسم الصلاة شاملا للصحيح والفاسد
حقيقة أو مجازا ولو صلى في أول الوقت صلاة صحيحة ثم صلاها في الوقت إما على وجه أكمل من الأول أو على خلافه فكلام الأصوليين يقتضي أنها لا تسمى إعادة بل أداء والأقرب إلى إطلاقات الفقهاء أنه تصدق الإعادة عليها واللغة تساعد على ذلك فليكن هذا هو المعتمد ولا يجئ مثل هذا في الصوم ولا في الحج فان من حج صحيحا ثم حج تائبا كانت حجته الأولى غير الثانية بخلاف الصلاة فان الثانية هي الأولى ولهذا ينوي فيه الفرض ولعل الأصوليين لا يوافقون على نية الفرض في الثانية ويقولون إن الثانية صلاة مبتدأة فلذلك عرفوا الإعادة بما ذكروه ولكن نفس الشريعة تخالفه ولو حج فاسدا ثم حج فقد قلنا إنه لا يسمى قضاء حقيقية وأما تسميته إعادة فلا يمتنع وهذا هو الذي وعدنا به من قبل فخرج من هذا أن الإعادة فعل مثل ما مضى فاسدا كان الماضي أو صحيحا أداه أو غيره فبين الأداء والإعادة عموم وخصوص من وجه ينفرد الأداء في الفعل الأول وتنفرد الإعادة فيما مضى إذا قضى صلاة وأفسدها ثم أعادها وفي الحج كما صورناه ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت على ما أخترناه خلافا للمصنف ومن وافقه وكذا يكون بين الإعادة والقضاء عموم وخصوص من وجه
وقد تكلم الفقهاء في إعادة صلاة الجنازة ولا أداء فيها إذ لا وقت يتعين ولا يسمى القضاء الأول إعادة لأن القضاء بأمر جديد فهو غير المأمور به في الوقت وإن سميناه قضاء للمشابهة كانت الاعادة تستدعي من المماثلة أكثر مما يستدعي القضاء وقول المصنف وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء موافق لقول المحصول إن الفعل لا يسمى قضاء إلا إذا وجد سبب وجوب الأداء مع أنه لم يوجد الأداء ومن هنا توهم بعضهم أن المندوب لا يسمى قضاء وأن قول الفقهاء بقضاء الرواتب مجاز والذي يقتضيه كلام الأكثرين والاصطلاح أنه لافرق بين الواجب والمندوب فينبغي أن يقال ووجد فيه سبب الأمر بها
واعلم أن الشرط المذكور أعني تقدم السبب يذكر في شيئين
أحدهما في الأمر بالقضاء فلا يؤمر بقضاء عبادة إلا إذا تقدم سبب الامر
بأدائها ونعني بالسبب ما هو مقتضى لوجوبها أو الندب إليها سواء أقارنه مانع من ترتب الحكم عليه أم لا ومتى تقدم السبب ولم تفعل أمر بقضائها ومتى لم يتقدم السبب أصلا لم يؤمر بالقضاء فلذلك تارك الصلاة عمدا يقضي لوجود السبب والوجوب والنائم يقضي لوجود السبب الذي قارنه مانع الوجوب وهو النوم والطفل لم يوجد في حقه السبب أصلا فلا يؤمر بالقضاء بعد البلوغ لا إيجابا ولا ندبا ولو أن المميز ترك الصلاة ثم بلغ فالظاهر أنه يستحب له قضاؤها كما كان يستحب له أداؤها إن قلنا كان مأمورا بأمر الشرع والحائض لا يستحب لها بعد الطهر قضاء الصلاة لأن سقوطها في حقها عزيمة فليست من أهل الصلاة فلم يوجد سبب الوجوب والمجنون سقوط القضاء في حقه رخصة لأنه إنما سقط عنه تخفيفا
الثاني مما يذكر فيه تقدم السبب تسمية القضاء اقتضى كلام الإمام أنه لا يسمى قضاء إلا إذا وجد السبب فيقتضي هذا أن الطفل لو أراد أن يقضي ما فاته في طفوليته لا يسمى ذلك قضاء ولا يصح قضاء بل إن صح صح فعلا مطلقا وهذا صحيح لأن القضاء يستدعي تقدم أمر وفوات أدائه فمتى لم يوجد استحالت هذه التسمية فقد تحرر أن الأداء فعل العبادة في وقتها والقضاء فعل العبادة خارج وقتها ولا حاجة إلى قيد آخر لأنه متى لم يتقدم سببها لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها والإعادة فعل العبادة من بعد أخرى إذا كانت أداء وقضاء أو غيرهما وقولنا فعل العبادة نعني به الواقعة فخرج به إنشاء التطوع التطوع بحج بعد حج الفرض أو بصلاة مطلقة بعد الفريضة والراتبة وظهر أن الإعادة تدخل في جميع العبادات والأداء والقضاء يدخلان في المؤقتة فقط وكل عبادة يصح وصفها بالأداء والقضاء إلا الجمعة فإنها توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء لأنها لا تقضي وأورد على هذا أنه لا يوصف بالشيء إلا ما أمكن وصفه بضده كالأجزاء والصحة لا يوصف بهما إلا ما أمكن وقوعه غير مجزئ وغير صحيح فكيف توصف الجمعة بالأداء إذ لا تقع غير مؤداة والجواب من وجهين
أحدهما منع تلك القاعدة على الإطلاق فقد يوصف بالشيء ما لا يوصف بضده وإنما خصوص الأجزاء والصحة اقتضى ذلك
والثاني أن الجمعة تقضي ظهرا وبين الجمعة والظهر اشتراك في الحقيقة فقبلت الوصف بذلك في الجملة وأيضا لو أنها وقعت بعد الوقت جمعة بجهل من فاعلها فنسميها قضاء فاسدا فصح وصف الجمعة بالأداء كما صح وصف الصلاة بالفساد وبقي من الاقسام الممكنة أن تقع العبادة المؤقتة قبل وقتها تعجيلا كإخراج صدقة الفطر في رمضان فلا يوصف بأداء ولا قضاء مع صحتها ووقوع الظهر قبل وقتها لا يوصف بأداء ولا قضاء مع فسادها وقول المصنف وأمكن أي الفعل ومثل المسافر والمريض ليتيبن أنه لا فرق بين كون مانع الوجوب من جهة العبد كالسفر أو من جهة الله تعالى كالمرض وسيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة السابعة من الفصل الثالث من هذا الباب الكلام في منع الفقهاء القائلين بأنه يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر
وقوله أو امتنع أي الفعل فإن النائم يمتنع منه عقلا أن يصلي والفقهاء يطلقون أن الصلاة واجبة عليه ولا يجب لذلك إلا ثبوتها في ذمته كما تقول الدين واجب على المعسر وقد ذكر القاضي أبو بكر أن الفقهاء يطلقون التكليف على ثلاثة معان
أحدها المطالبة بالفعل أو الترك
والثاني بمعنى أن عليه فيما سهى عنه أو نام فرضا وإنما يخاطب بذلك قبل زوال عقله وبعده فيقال له إذا نسيت أو نمت في وقت لو كنت فيه ذاكرا أو يقظان لزمتك فقد وجب عليك قضاؤها
والثالث على الفعل الذي ينوب مناب الواجب كصلاة الصبي وصوم المريض وجمعة العبد إذا حضرها وفعلها وحج غير المستطيع ويطلقون التكليف في ذلك وهذا الذي نقله القاضي من اصطلاحهم فائدة توجب رفع الخلاف بين الفريقين في المعنى وامتناع الصوم شرعا على الحائض بالإجماع فيحرم عليها ولا يصح وإمكانه من المسافر وصحته والاعتداد به لم يخالف فيه إلا
الظاهرية فقالوا إنه لا يجزئه لقوله تعالى فعدة من أيام أخر وهو محجوبون بالأخبار التي تدل على الصوم في السفر في رمضان ومعنى الآية فأفطر فعدة من أيام أخر
ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه فإن عاش وفعل في آخره فقضاء عند القاضي أداء عند الحجة إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه
قوله تضيق عليه معناه يقضي بالتأخير عنه والحجة هو الغزالي والحق معه في هذه المسألة وبدليله يعرف أن التضيق ليس في نفس الأمر والقاضي هو ابن الباقلاني ورأيته في كلامه في التقريب وهو إنما يعتبر الظاهر فيحكم بالتضييق فيكون الوقت قد خرج وهو ضعيف لأنا نعرف من نفس الشرع الفرق بين اسم الزاني والواطئ لامرأته يظنها أجنبية فالثاني إنما يأثم بجرأته بحسب ظنه والأول يأثم بجرأته وبحصول المفسدة التي نهى الشرع عنها
التقسيم السادس للحكم إلى العزيمة والرخصة
السادس الحكم إن يثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة كحل الميتة للمضطر والقصر والفطر للمسافر واجبا ومندوبا ومباحا وإلا فعزيمةالرخصة بإسكان الخاء وضمها مع ضم الراء التسهيل فرخصة الله تسهيله على عباده هكذا يقتضيه كلام أهل اللغة وهو يقتضي أن الرخصة من أقسام الحكم كما اقتضاه كلام المصنف لا من أقسام متعلقاته كما اقتضاه قول غيره الرخصة ما جاز الإقدام عليه مع قيام المانع ولم أر لهذا الثاني مستندا من اللغة إلا قولهم هذا رخصتي من الماء أي شربي منه ويناسبه قول بعض الأصوليين إنها اليسر والسهولة وأما بفتح الخاء فلم أرها في اللغة ولا حفظ هذا الوزن إلا في الثلاثي المجرد كلقطة وهزأة ولمزة وهمزة وحطمة وخدعة وهو يكون للفاعل وللمفعول فإن ثبت هنا فقياسه أن يكون للشخص الكبير الترخيص على غيره أو المرخص فيه وذكر الإمام أن الرخصة ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع فأورد عليه الحدود والتقادير الجائزة مع تكريم الآدمي المقتضى للمنع منها فقيده بعضهم باشتهار المانع وبعضهم بكونه لضرورة أو حاجة وبعضهم بكونه لغرض التوسع وربما زيد فيه في حالة جريه احتراز من القصاص والعفو فإنه تخفيف من الله ورحمة ولا يسمى رخصة لأنه فاعله بدله وقولنا مع قيام المانع احتراز من أن يكون منسوخا كالآصار التي كانت على من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا ولا يسمى ناسخها رخصة
وقول المصنف على خلاف الدليل هو معنى قولنا مع قيام المانع وقوله لعذر يريد به التسهيل في بعض الأحوال فيخرج به التخصيص ونحوه ويستقيم به حد
الرخصة وقوله كحل لو قال كإحلال كان أحسن لأن نوع الحكم الإحلال لا الحل وقد عهد له مثل هذا التسمح من تفسير الرخصة بالتيسير فيكون الحل مطابقا بغير تسمح وقوله والقصر والفطر لك أن تعطفهما على حل أي وكالقصر وعلى الميتة أي وكحل القصر وقوله واجبا ومندوبا ومباحا أحوال إما من قوله فرخصة وإما من حل إن لم يعطف عليه وتكون قد استعملته في القدر المشترك بين الثلاثة وإما أن يتعدد صاحب الحال لتعددها فتقدر كحل الميتة للمضطر واجبا والقصر مندوبا والفطر مباحا
واعلم أن الإيجاب والندب واستواء الطرفين أو رجحان أحدهما أمر زائد على معنى الرخصة لأن معناها التيسير وذلك بحصول الجواز للفعلى أو الترك يرخص في الحرام بالإذن في فعله وفي الواجب بالإذن في تركه وأدلة الوجوب والندب وغيرها تؤخذ من أدلة أخرى ولهذا اقتصر الكتاب العزيز على الجواب في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه وقوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فاقتصر كما نراه على نفي الإثم والجناح ولم يصرح بالإذن فعلنا الجواز برفع الاثم والجناح وإنما يكون القصر مندوبا إذا بلغ سفره ثلاثة أيام وإباحة الفطر قد يكون مع رجحانه إذا كان المسافر يجهده الصوم وقد يكون مع مرجوحيته إذا كان يطيقه ويسهل عليه وقوله وإلا فعزيمة أي وإن ثبت لا على خلاف الدليل أو على خلاف الدليل لكن ليس لعذر على وجه التيسير فعزيمة سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا أم مكروها أم حراما من جهة أنه يجزم أمره أي قطع وحتم سهل على المكلف أم شق مأخوذ من العزم وهو القصد المصمم والعزيمة مصدر عزم فهي أيضا قسم من أقسام الحكم لا من أقسام الفعل الذي هو متعلقه
وقول غيره العزيمة ما جاز الإقدام عليه لا مع قيام المانع فيه من التسمح قدمناه
الفصل الثالث في أحكام الحكم وفيه عدة مسائل
الأولى الواجب المعين والمخيرالفصل الثالث في أحكامه وفيه مسائل الأولى الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة كخصال الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمامة وقالت المعتزلة الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به خلاف في المعنى وقيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس ورد بأن التعين يحيل ترك ذلك الواحد والتخيير يجوزه وثبت اتفاقا في الكفارة فانتفى الأول قيل يحتمل أن المكلف يختار المعين أو يعين ما يختاره أو سقط بفعل غيره وأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه وهو خلاف النص والإجماع وعن الثاني بأن الوجوب محقق قبل اختياره وعن الثالث بأن الآتي بأيهما آت بالواجب إجماعا قيل إن أتى بالكل معا فالامتثال أما بالكل فالكل واجب أو بكل واحد فيجتمع مؤثرات على أثر واحد أو بواحد غير معين ولم يوجد أو بواحد معين وهو المطلوب وأيضا الوجوب معين فيستدعي محلا معينا وليس الكل ولا كل واحد وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك فإذا الواجب واحد معين وأجيب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد وتلك معرفات وعن الثاني بأنه يستدعي أحدها لا بعينه كالمعلول المعين المستدعي علة من غير تعيين وعن الآخرين بأنه يستحق ثواب وعقاب أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها
قوله في أحكامه يعني في أحكام الحكم وذكر في هذا الفصل سبع مسائل
والإمام ذكرها بعينها في باب الأوامر في القسم الثاني منه في المسائل المعنوية وجعل المسائل الثلاث الأولى في أقسام الوجوب لأنه بحسب المأمور به ينقسم إلى معين ومخير وبحسب وقت المأمور ينقسم إلى مضيق وموسع وبحسب المأمور ينقسم إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية وجعل المسائل الأربع الأخيرة في أحكام الوجوب ولو فعل المصنف كذلك كان أحسن وكأن عذره في ذلك المخير والموسع وفرض الكفايةف مما وقع الكلام فيه وفي تحقيق عروض ذلك الواجب فحسن البحث في أن الوجوب هل له ذلك أو لا وهو حكم وبعد ثبوت هذا الحكم تصير الثلاثة المذكورة أقساما للوجوب الذي هو قسم من أقسام الحكم فصح كل من الاعتبارين وقوله بمعين يعني معين النوع وإلا فالتعيين بالشخص لا يتعلق الوجوب به لأن الشخص دخل في الوجود وما دخل في الوجود لا يصح التكليف به لمراده المعين المعلوم المتميز وقوله وقد يتعلق بمبهم إشارة إلى أن المختار أو الواجب لا بعينه ونقل القاضي إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء عليه خلافا لكثير من المعتزلة وقوم من نوابذ الفقهاء المعينين لهم على بدعتهم في قوله أن الكل واجب وحرر بعض المتأخرين معنى الإبهام في ذلك فقال إن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها وعندي زيادة تحرير أخرى وهو أن القدر المشترك يقال على المتواطئ كالرجل فلا إبهام فيه فإن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق ويقال على المبهم بين شيئين أو أشياء كأحد الرجلين والفرق بينهما أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية
والثاني قصد فيه أخص من ذلك وهو أحد الشخصين بعينه وإن لم يعين و ولذلك سمي مبهما لأنه أبهم علينا أمره والأول لم يقل أحد بأن الوجوب يتعلق بخصوصياته كالأمر بالإعتاق فإن مسمى الإعتاق ومسمى الرقبة متواطئ كالرجل فلا يتعلق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين ولا على التخيير ولا يقال فيه واجب مخير ولا يأتي فيه الخلاف وأكثر أوامر الشريعة من ذلك
والثالث متعلق بالخصوصيات فلذلك وقع الخلاف فيه وأجمعت الأمة على إطلاق الواجب المخير عليه ولا منافاة بين ما قلناه وما حكيناه عن بعض المتأخرين من تعلق الوجوب بالقدر المشترك لكن ما قلناه زيادة وهي تبيين أن ذلك القدر المشترك أخص منظور فيه إلى الخصوصيات وقول المصنف من أمور معينة إنما قيد بقوله معينة لأنها إذا كانت غير معينة فإما أن يقع التكليف بالقدر المشترك بينها من غير نظر إلى الخصوصيات فذلك لا يسمى إيهاما بل هو كالإعتاق على ما سبق وليس كلامنا فيه وإما أن ينظر إلى الخصوصيات كما ذكرناه في غير الإبهام فيستحيل لعدم العلم بها ونحن مرادنا هنا بالمعينة المعلومة المتميزة فلذلك قيد بقوله المعينة ليبين صورة المسألة وخصال الكفارة يعني كفارة اليمين وهي الإعتاق والإطعام والكسوة فإنها يخير فيها وكذا ما هو على التخيير من كفارات الحج وقوله ونصب أحد المستعدين للامامة يعني إن خلا الوقت عن إمام وهناك جماعة يجب نصب واحد وكذا قال غيره وهو صحيح إلا أنه من القسم الأول الذي قلنا إن الوجوب فيه متعلق بالقدر المشترك من غير نظر إلى الخصوصيات كاعتاق رقبة فينبغي ألا يمثل به وجماعة من أصحابنا ومن المعتزلة ذكروا أمثلة من الواجب المخير بين القسمين جميعا والصواب ما قدمته نعم في أهل الشورى الذي جعل عمر رضي الله عنه الأمر فيهم ونحوه يتعلق الأمر بأعيانهم فيحسن أن يكون مثالا للواجب المخير وقول المعتزلة إن الكل واجب على المعنى المذكور مأخذهم فيه أن الحكم يتبع الحسن والقبح فإيجاب شيء يتبع لحسنه الخاص به فلو كان واحد من الثلاثة واجبا والاثنان غير واجبين لخلا اثنان عن المقتضى للوجوب فلا بد أن يكون كل واحد لخصوصه مشتملا على صفة تقتضي وجوبه وكل منهما يقوم مقام الآخر فيوصف كل منهما بالوجوب والتخيير معا
وتحقيق هذا الكلام إنما ينتج أن المشتمل على الحسن المقتضي للوجوب هو أحدها لا خصوص كل منها فلذلك كان معنى كلامهم إيجاب أحدها على الإبهام وإنما قصدوا الفرار من لفظ يوهم أن بعضها واجب وبعضها ليس بواجب وأنه لا يخير بين الواجب وبين غيره وأصحابنا لا يراعوان الحسن والقبح ويجوزون التخيير
بين ما يظن أن فيه مصلحة وبين ما لا مصلحة فيه ومع ذلك لم يقولوا بوجوب واحد معين وإنما قالوا بوجوب أحدها من غير تعيين لأنه مدلول لفظ الأمر ومدارهم في إثبات الأحكام فإذا نظرنا إلى مجرد ذلك لم يكن فرق في المعنى بين مذهب أصحابنا ومذهب المعتزلة وبذلك صرح طوائف منا ومنهم وتبعهم المصنف وإذا دققنا البحث وقررنا ما قدمناه من الفرق بين أن يراد مع القدر المشترك الخصوصيات أولا أمكن أن يقال في خصال الكفارة احتمالان
أحدهما أن يكون الواجب القدر المشترك بين الخصال
والثاني أن يكون كل خصلة واجبة على تقدير ألا نفضل عنها وكل من الاحتمالين يمكن أن يقرر على مذهبنا ومذهبهم والأقرب إلى الكلام الفقهاء الثاني وبه يفترق الحال بينه وبين إعتاق رقبة فإن الثابت فيه الأول لا غير وقول المصنف فلا خلاف في المعنى قد علمت أنه يمكن تمشيته ويمكن التوقف فيه لظهور معنيين يمكن أن يذهب إلى كل منهما ذاهب والأوفق بقواعد المعتزلة الأول وهو تعلق الوجوب بالقدر المشترك لا غير حتى يكون هو الموصوف بالحسن وبقواعدنا يصح ذلك وغيره وهو الأقرب إلى كلام الفقهاء وهو المختار وإن يكن بين المعنيين تباعد لكن يظهر أثره في أمور منها أنه إذا فعل خصلة يقال على ما اخترناه إنها الواجب وأما على المعنى الآخر فينبغي أن يقال إن الواجب تأدى بها لا أنها هي الواجب
وقوله قيل الواجب معين عند الله دون الناس هو قول ترويه المعتزلة عن أصحابنا ويرويه أصحابنا عن المعتزلة واتفق الفريقان على فساده وعندي أنه لم يقل به قائل وإنما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع ذلك فصار معنى يرد عليه وأما رواية أصحابنا عن المعتزلة فلا وجه له لمنافاته قواعدهم
وقوله رد بأن التعيين يحيل ترك الواحد أي لأن الواجب لا يجوز تركه والتخيير يجوزه أي يجوز الترك ضرورة فلازم التعيين ولازم التخيير لا يجتمعان فالملزومان وهما التعيين والتخيير لا يجتمعان لأنهما لو اجتمعا لاجتمع لازمهما لأنه
يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم والتخيير ثابت بالإتفاق في الكفارة فانتفى التعيين
وقوله قيل يحتمل أن المكلف يختار المعين أو يعين ما يختاره أو يسقط بفعل غيره يعني وعلى كل من الاحتمالات الثلاثة لا يتنافى التعيين والتخيير أما في الأول فلأن التعيين في نفس الأمر والتخيير في الظاهر وأما الثاني فلأن التخيير قبل الاختيار والتعيين بعده وأما الثالث فلأنا نمنع أن الواجب لا يجوز تركه مطلقا بل هو الذي لا يجوز تركه بغير بدل
وقوله وأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه أي إذا اختار بعضهم الإطعام وبعضهم الكسوة وبعضهم الإعتاق يكون الواجب على كل منهم ما اختاره معينا عند الله وهو خلاف الإجماع لإجماع العلماء على أن حكم الله في كفارة اليمين واحد بالنسبة إلى الجميع وعن الثاني بأن الوجوب تحقق قبل اختياره وإلا لما أثم بتركه فإما أن يكون معينا أو مخيرا إن كان معينا عاد الكلام وإلا بطل قولهم وعلى الثالث أن الآتي بأيها آت بالواجب لأنه في ضمنه وعلى كل التقديرين لا يكون الواجب حارجا عنه فلا يسقط بفعل غيره ووليس كالسنة المجزئة عن الفرض ولا كالبدل المجزئ عن المبدل
وقوله قيل إن أتى بالكل معا يعني دفعة واحدة إما بنفسه إن أمكن ذلك أو بوكلاء فالامتثال إما بالكل أي المجموع فالمجموع واجب ومن ضرورته وجوب كل واحد وإن كان الامتثال بكل واحد فيجتمع مؤثرات على أثر واحد وهو محال لأن المؤثر التام يستغني به الأثر عن غيره مع احتياجه إليه فلو اجتمع مؤثران على أثر واحد لاحتاج إليهما واستغنى عنهما ويلزم أن يقع بهما وإن لا يقع بهما فيجتمع النقيضان وإن كان الامتثال بواحد غير معين فغير المعين لا وجود له لأن كل موجود معين كما أن ما ليس بمعين ليس بموجود لأنه عكس نقيضه ولما بطلت هذه الأقسام الثلاثة تعين الرابع وهو أن الامتثال بواحد معين وهو المطلوب لأن ما وقع به هو المأمور به وأيضا الوجوب صفة الواجب وهو صفة معينة فلا بد أن يكون موصوفها معينا وليس المجموع ولا
كل واحد ولا واحدا غير معين لما سبق فثبت أنه معين وأيضا إذا أتى بالجميع فإن أثيب ثواب الواجب على المجموع أو على كل فرد أو على غير معين لزم ما سبق فلا يثاب إلا على واحد معين وأيضا إذا تركت الجميع إن عوقب على المجموع أو على كل واحد أو على واحد معين لزم ما سبق فلا يعاقب إلا على ترك واحد معين فهذه أربعة أدلة استدل بها القول المردود
وقوله وأجيب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد وتلك الخصال معرفات لا مؤثرات فلا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد وأما المعرفات فيجوز اجتماعها على الشيء كافراد العالم للصانع وهذا الجواب يحتمل أمرين أن يكون المقصود منه الرد على الاستدلال فقط من غير بيان ما يعتقده من أن الامتثال بماذا وكأنه يقول دليلك لا ينتج أن الواجب واحد معين لاحتمال أن يكون الواجب كل واحد ويكون الامتثال بكل واحد ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد وهذا إذا فسرنا الامتثال بفعل الواجب يلزم عليه أن ما يقع به الامتثال واجب ويكون الجواب على هذا جدليا والجواب التحقيقي أن الامتثال بواحد لا بعينه وهو موجود في ضمن كل واحد
الثاني أن يكون جوابا تحقيقيا فإن الامتثال معناه إما فعل يتضمن مثل المأمور به إذا جعلناه افتعالا من المثل الذي هو الشبه وإما الانتصاب والقيام لأداء المأمور به إذا جعلناه من مثل على وزن ضرب أي انتصب وعلى كلا التقديرين لا يستلزم أن يكون الممتثل به هو الواجب بل أن يكون الواجب يحصل به ولا شك أن الواجب حاصل في هذه الصورة بكل واحد لتضمنه له وقصده فيكون الامتثال بكل واحد وبالمجموع أيضا لتضمنه الواجب وهذا واحد لا بعينه أو يكون الإمتثال بكل واحد وكل واحد واجبا على معنى ما قدمناه عن الفقهاء فيصير جوابا تحقيقيا على المذهبين وفي الوجه الأول هو جواب جدلي على المذهبين
وقوله بواحد غير معين ولم يوجد جوابه أن غير المعين له معنيان
أحدهما المقيد بقيد عدم التعيين وهذا هو الذي لم يوجد
والثاني أخذه لا بقيد عدم التعيين وهذا موجود في ضمن المعين وهو المقصود هنا فقولك ولم يوجد ممنوع وهذا جواب تحقيقي على المعنى المتفق عليه في المذهبين وقوله بواحد معين وهو المطلوب وعللناه بأن ما وقع الامتثال به هو الواجب يتوجه عليه منع لما قدمناه في تفسير الامتثال وقوله عن الثاني يعني الوجوب وصفه معين فيستدعي محلا معينا فإنه يستدعي أحدها لا بعينه كالحرارة وهي معلول معين يستدعي إما الشمس وإما النار فهي علة غير معينة
واعلم أن المعين يطلق على الشخص وليس هو المراد هنا في الطرفين ويطلق على المعلوم التمييز فإنه له تعين بوجه ما ويطلق على أحدها أيضا أنه يتعين بهذا الاعتبار ويطلق على ما ليس بينه وبين غيره إبهام فأحدها بهذا التفسير غير معين والوجوب معين فلذلك جرى البحث ولا يلزم أن يكون المحل مساويا للحال في ذلك وقوله عن الآخرين يعنى الثواب والعقاب بأنه مستحق ثواب أمور ولا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها يعني ثواب واجبات مخيرة وهو أزيد من ثواب بعضها سواء اقتصر عليه أو ضم إليه نفلا آخر أو نقص من ثواب الواجبات المعينة ولكل منها رتبة من الثواب عند الله تعالى وكذا العقاب إذا تركها يستحق فالعقاب على ترك مجموع أمور كان المكلف مخيرا بين ترك أي واحد شاء منها بشرط فعل الآخر
وقال بعضهم في الثواب والعقاب إنه يستحق ثواب الواجب على فعل أكثرها ثوابا ويستحق على الترك عقاب أدونها عقابا فأما ما قاله في العقاب فيظهر اتجاهه وما قاله في الثواب مراده به الثواب على الواجب وما عداه تطوع يثاب عليه ثواب التطوع وبهذا يعلم أن الخلاف في الثواب خلاف في أنه إذا فعل الجميع ما الذي يقع واجبا وحكي القاضي قولا ثالثا أن الذي يقع واجبا هو العتق لأنه أعظم ثوبا لأنه أنفع وأشق على النفس وأرد عليه بأنه قد لا يكون كذلك ويحتمل عندي قول رابع وهو أنه لا يثاب ويعاقب إلا على أحدها لأنه الواجب على قولهم وهذا الخلاف شبيه بالخلاف فيما إذا طول الطمأنينة في الصلاة أو مسح جميع الرأس في الوضوء هل يقع الجميع واجبا أولا ويعلم أن
محل الأقوال الأربعة إذا فعل الجميع أما قيد الفعل فليس إلا ما قدمناه من أحدها والجميع
فرع إذا باع قفيزا من صبرة فالمعقود عليه قفيز لا بعينه يعني القدر المشترك بين أقفزة الصبرة وقالوا إن معناه كل واحد منها على البدل كما قالوا في خصال الكفارة وعندي أنه كعتق الرقبة وقد تقدم تحريره وإذا اختار المشتري واحدا منها لا يقول إنه كان معينا بل يعين فيه إبهامه وكذا إذا دعت المرأة إلى تزويجها من كفؤين زوجت من أحدهما كالمستعدين للإمامة وإذا طلق إحدى امرأتيه أو أعتق إحدى عبديه فهو كخصال الكفارة سواء والاختصاص للطلاق والعتق بواحد معين فإذا اختار تعين ما يختاره
تذنيب
الحكم قد يتعين على الترتيب فيحرم الجمع كأكل المذكى والميتة أو يباح كالوضوء والتيمم أو يسن ككفارة الصومالتذنيب من قولهم الرجل عمامته إذا أفضل منها شيئا فأرخاه كالمذنب وذنبت البسرة بدأ فيها الإرطاب من قبل ذنبها فالتذنيب هنا معناه تتمة للمسألة وليس فرعا منها لأنها في المخير وهو في المرتب ولكن التخيير والترتيب اشتركا في أن كلا منهما حكم يتعلق بأمور فإباحة الميتة مرتبة على إباحة المضطر ويحرم الجمع بينهما الاضطرار المبيح الميتة ووجوب التميم وإباحته مرتب على الوضوء لاختصاصه بحالة العجز وقال المصنف إنه يباح الجمع بينهما وكذا في المحصول وغيره وكنت أصور هذا للطلبة بما إذا خاف من استعمال الماء لمرض ولم ينته خوفه إلى أن يظن المانع من جواز استعمال الماء فإنه يباح له التيمم لأجل الخوف ولا يمتنع الوضوء لعدم تحقق الضرر فإذا تيمم صح تيممه فإذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك جاز كما قيل في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم وإذا جعلناه خطابا لمن يمكنه الصوم ولا يطيقه كالشيخ الكبير فيجوز له الفطر والفدية ولو حمل على نفسه وصام كان خيرا له ولا يقال فكان على قياس هذا أن يسن الجمع لأن الوضوء أفضل لأنا نقول صحيح إن الوضوء أفضل لكن كلامه في الجمع وهو يحصل بإضافة التيمم إليه وليس بأفضل بل هو مباح وهذا التصوير على حسنه يخدش فيه شيء واحد وهو أنه إذا توضأ بطل التيمم فإنها طهارة ضرورة ولا ضرورة هنا فلم يجمع الوضوء والتيمم وإذا لم يكن اجتماعهما لا يوصف بالإباحة ولا بغيرها
قوله ككفارة الصوم يعني ككفارة الوقاع في صوم رمضان يجب به الإعتاق
فإن لم يجد فالصيام فإن لم يجد فالإطعام وكذا كفارة الظهار ولو مثل بها المصنف كان أحسن للنص عليها في القرآن وكفارة والوقاع قال بالتخيير فيها يمكن حمل كلام المصنف على الصوم في كفارة اليمين فإنه مرتب على الخصال الثلاث المخير فيها وأيا ما كان فالحكم بأن الجمع سنة يحتاج إلى دليل ولا أعلمه ولم أر أحدا من الفقهاء صرح باستحباب الجمع وإنما الأصوليون ذكروه ويحتاجون إلى دليل عليه ولعال مرادهم الورع والإحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة كما أعتقت عائشة رضي الله عنها عن نذرها في كلام ابن الزبير رقابا كثيرة وكانت تبكي حتى تبل دموعها خمارها
وهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف في المرتب ولعلهم أيضا لم يريدوا أن الجمع قبل فعله مطلوب بل إذا وقع كان بعضه فرضا وبعضه ندبا وعبارة القاضي تقتضي هذا ويكون هذا من باب النوافل المطلقة ومثل القاضي بالمسح والغسل أيضا فإن أراد مسح الخف فالقول بأنه إذا فعله بعد غسل الرجل يكون مندوبا في غاية البعد وإذا كفرنا بالعتق صار بنية الكفارة ينبغي أن يأتي فيه الخلاف المشهور في أنه إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم وهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف في المرتب ذكر في المحصول مثلها في المخير أيضا ومثل المحرم بتزويج المرأة من كفؤين والمباح بستر العورة بثوب بعد ثوب المندوب بالجمع بين خصال كفارة الحنث وحكمه بندب الجمع في خصال كفارة اليمين يحتاج إلى دليل كما قدمناه وتمثيله المخير بالتزويج من كفؤين والستر بثوبين مبني على ما سبق منه ومن غيره
وعندي أن الواجب القدر المشترك كما سبق لكن التمثيل صحيح فيه أيضا
المسألة الثانية في الواجب الموسع والمضيق
الثانية الوجوب إن تعلق بوقت فإما إن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق أو ينقص عنه فيمنعه من يمنع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبيرة أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل في جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض وقال المتكلمون يجوز تركه في الأول بشرط العزم وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل ورد بأن العزم لو صح بدلا لتأدى الواجب به وبأنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد ومنا من قال يختص بالأول وفي الآخر قضاء وقالت الحنفية يختص بالآخر وفي الأول تعجيل وقال الكرخي الآتي في الأول إن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا احتجوا بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه قلنا المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائهكما أن الواجب ينقسم إلى معين ومخير كذلك ينقسم إلى مضيق وموسع والمضيق والموسع بالحقيقة هو الوقت ويوصف به الواجب والوجوب مجازا ومقصوده بالواجب الفعل الواجب إن زاد وقته على قدره فهو الموسع وإلا فهو المضيق وعلى هذا قسمان
أحدهما أن يساويه فيجوز التكليف به وقد وقع كصوم نهار رمضان لا يزيد الزمان على الواجب ولا الواجب على الزمان
والثاني أن ينقص الوقت عن الفعل فإن كان الغرض من ذلك وقوع الفعل جميعه في الزمان الذي لا يسعه فلم يقع هذا في الشريعة وهو تكليف ما لا يطاق يجوزه من جوزه ويمنعه من منعه وإن كان الغرض أن يبتدئ في ذلك الوقت ويتمه بعد ذلك أو يثبت في ذمته ويفعله كله بعد ذلك فهذا جائز وواقع بينهما فيما لو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض وقد بقي من الوقت مقدار ركعة ووسع ما بعده بقيتها فإن تلك الصلاة تجب وكذا إذا بقي مقدار تكبيرة على أصح القولين كالركعة وهذا يطرد في الصلوات الخمس وإذا كان كذلك في آخر وقت صلاة يجمع ما قبلها معها كالعصر والعشاء فتجب الأولى أيضا فيها الظهر والمغرب وكذلك مثل المصنف بالظهر وأطلق القضاء حتى يشتمل وقت الضرورة وهو وقت العصر بالنسبة إليها
والضمير في قول المصنف يساوي وينقص ويزيد للوقت وفي قوله وهو تصح إعادته للوقت والوجوب وللواجب وهو مقصوده على ما سبق
وقوله لغرض كأنه بنى على قول من يقول إن الصلاة إذا وقع بعضها خارج الوقت يكون قضاء أما كلها وإما الخارج عنها والصحيح من مذهب الشافعي أنه متىى وقع ركعة منها في الوقت فالكل أداء ولم يقل بأن وقت الصبح مثلا يخرج بطلوع الشمس مطلقا بل قال إن طلعت الشمس ولم يصل منها ركعة فقد خرج وقتها واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه و سلم من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وقليل من الفقهاء اليوم من يحرر هذا بل يعتقد أن الحكم بالأداء يجعل ما بعد الوقت تابعا للركعة الواقعة في الوقت مع
خروج الوقت ولو حمل كلام المصنف على القضاء اللغوي انتفى عنه هذا الاعتراض
وقوله للظهر قد بينا أنه لااختصاص لهذا الحكم بها وقوله الزائل عذره مستنده تسمية الفقهاء الأشياء المذكورة أعذارا وإن كان الفكر ليس بعذر وقوله تكبيرة بناء على الأصح
وقوله فيقتضي من هنا إلى آخر الكلام في حكم الواجب الموسع
واعلم أن الناس اختلفوا فمنهم من اعترف به ومنهم من أنكره أما المعترفون به فجمهور الفقهاء وجمهور المتكلمين من الأشعرية ومن المعتزلة وهؤلاء المعترفون اختلفوا في جواز تركه أول الوقت بلا بدل مع اتفاقهم على أنه يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء كان فجمهور الفقهاء قالوا بجواز تركه في أوله بلا بدل ولا يعصى حتى يخلو الوقت كله عنده وهذا الذي قدمه المصنف وجمهور المتكلمين قالوا لا يجوز تركه إلا ببدل واتفقوا على أن ذلك البدل هو العزم فإذا تضيق الوقت تعين الفعل ونصر القاضي هذا القول ورده الإمام وغيره بأن العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به وفي هذا الرد نظر لأن لهم أن يقولوا هو بدل عن فعله في أول الوقت لا عن فعله مطلقا إلا أن ذلك يعكر عليهم لأن فعله في أول الوقت لخصومه ليس بواجب فلا يحتاج تركه فيه إلى بدل فالجواب المحرر أن يقال إما أن يكون الفعل في الأول واجبا أولا إن لم يكن فلا حاجة إلى البدل وإن كان فإما أن يكون كل الواجب أولا إن كان فيتأدى ببدله وإلا فيلزم أن يكون واجبان ولا دليل عليه
وقوله لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد ممنوع أن المبدل واحد لأن العزم في الجزء الأول بدل عن الفعل في الجزء الأول والعزم في الجزء الثاني بدل عن الفعل في الجزء الثاني فالبدل متعدد والمبدل متعدد وإنما الوجوب ما ذكرناه وهنا فرغ الكلام على الفرق المعترفين بالواجب الموسع وأما المنكرون له فقد تضمنهم قوله ومنا إلى آخره وجميعهم ثلاث طوائف وزاد غيره رابعة وفرقة خامسة قالوا يختص بالأول فإن فعله فيه كان أداء وإن أخره وفعله في آخر الوقت كان قضاء وهذا القول نسب إلى
بعض أصحابنا وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه ولا يوجد في شيء من كتب المذهب ولى حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول أصحابنا إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا
وقول بعضهم تجب في أول الوقت وينصبون الخلاف في ذلك مع الحنفية وقولهم إنما يجب بآخره وقصد أصحابنا بقولهم تجب الصلاة في أول الوقت كون الوجوب في أول الوقت لا كون الصلاة في أول الوقت واجبة فحصل الالتباس في العبارة ومتعلق الجار والمجرور ثم وقفت في الأم في كتاب الحج في ذلك الجزء الخامس قال الشافعي ذهب بعض أهل الكلام أن فرض الحج على المستطيع إذا لزمه في وقت يمكنه فتركه في أول ما يمكنه كان آئما كمن ترك الصلاة حتى ذهب الوقت ويجزئه حجة بعد أول سنة من مقدرته قضاء كالصلاة بعد ذهاب الوقت ثم أفادنا بعضهم ذلك في الصلاة إذا دخل وقتها الأول فتركها وإن صلاها في الوقت وفيما نذر من صوم أو وجب عليه بكفارة أو قضاء فقال فيه كله متى أمكنه فأخره فهو عاص بتأخيره ثم قال في المرأة يجبر أبوها وزوجها على تركها لهذا المعنى وقاله معه غيره ممن يفتي انتهى
فقد ثبت بنقل الشافعي هذا المذهب عن غيره فلعل بعض الناس نقل ذلك عن نقل الشافعي فالتبس ذلك على بعده وظن أنه من مذهب الشافعي وعلى كل تقدير لايخرج نقله عن أصحابنا عن الوهم ثم ظاهر كلام الشافعي كما ترى أن القائل به يقول بالإثم والعصيان بالتأخير عن أول الوقت والقاضي أبو بكر نقل إجماع الأمة على أن المكلف لا يأثم بتأخيره عن أول الوقت ولذلك قال بعضهم إنه في آخر الوقت يسد مسد الأداء وما نقله الشافعي أثبت وأولى وينبغي إسقاط هذه اللفظة والإقتصار على قوله قضاء كما فعل المصنف وعدم نسبة ذلك إلى بعض أصحابنا بل ينقله قولا مطلقا كما نقله القاضي قولا مطلقا
ولم يرد المصنف على هذا القول ووجه الرد عليه عدم دلالة الأمر المطلق
على الفور مع ظهور الأدلة من الكتاب وسير السلف على جواز التأخير إلى أثناء وقت الصلاة
الفرقة الثانية الحنفية
قالوا يختص بالآخر وفي الأول تعجيل يسقط الفرض به أو نفل يمنع من الوجوب على اختلاف عنهم في المنقول
الثالثة مقالة الكرخي
المقالة الرابعة حكيت عن الكرخي أن الواجب يعين بالفعل في أي وقت كان
المقالة الخامسة أن الوجوب يختص بالجزء الذي يتصل الأداء به وإلا فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه وهذا هو المشهور عند الحنفية لأن سبب الوجوب عندهم كل جزء من الوقت على البدل إن اتصل به الأداء وإلا فآخره وإنما عدت هذه الفرقة من المنكرين للواجب الموسع مع قولهم إن الصلاة مهما أديت في الوقت كانت واجبة لأنهم لم يجوزوا أن يكون الوقت فاضلا عن الفعل وقول المصنف احتجوا أي الحنفية ومن قال قريبا من قولهم كالكرخي وبقية المقالات التي حكيناها
وقولهم وجب في أول الوقت فيه ما نبهنا عليه من الإلباس لأن فيه معنيين
أحدهما لو وجب في أول الوقت فعله في أول الوقت وهذا هو الذي قصدوه وقولهم مع ذلك لم يجز تركه يمكن منعه على مذهب المتكلمين لأن الواجب لا يجوز تركه وترك بدله أما تركه وحده مع الإتيان ببدله فجائز ويمكن تسليمه ولا يضرنا
والمعنى الثاني لو وجد في أول الوقت فعله في أي جزء كان وهذا مقصودنا ومع هذا لا يصح قولهم لم يجز تركه في أول الوقت لأن الذي لا
يجوز تركه هو الواجب وفعله أول الوقت ليس بواجب والواجب هو الفعل في أي جزء كان وهذا يجوز تركه وهذا معنى قول المصنف قلنا المكلف بخير
فائدة قول المصنف إن تعلق بوقت يحتمل أن يريد به أن تعلق الوقت على سبيل القصد كما فسرنا العبارة المؤقتة به فيما سبق ويحترز به عما لا يكون لذلك فلا يقال فيه ينقسم إلى مضيق وموسع وإن كان يلزمه الوقت لأن الفعل لا بد له من وقت وعلى هذا الواجب على الفور الذي لم ينص على وقته لا يقال فيه موسع ويحتمل أن يريد أنه متى تعين وقته سواء كان تعيينه بالنص عليه أم بدلالة الأمر عند من يراه فينقسم إلى مضيق وموسع ويكون كل واجب مضيقا أو موسعا فما كان للتراخي فهو موسع بلا إشكال وما كان للفور ليس بموسع والحج من قال بفوريته إن أطلق يلزمه ذلك وإن أراد إيقاعه في السنة الأولى من سني الإمكان يصير أشهر الحج من تلك السنة بالسنة إلى ابتدائه كالوقت الموسع لكن ينبغي أن يعذر في التأخير إلى آخرها لأنه مغيا بيوم عرفة وأما التوسعة فيما بعد السنة الأولى فلا وجه لها مع القول بالفور
فرع الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت فله التأخير ما لم يتوقع فواته إن أخر لكبر أو مرض إذا أثبتنا الواجب الموسع فقد يكون وقته محدودا بغاية تعلق به كالصلاة وقد يكون مدة العمر كالحج وقضاء الفائت حيث قلنا بأنه على التراخي وهو إذا فات يعذر على الصحيح دون الفائت بغير عذر فإنه على الفور على الصحيح عندهم وهذكا فصلوا في الكفارات بين ما سببها معصية وغيرها وحيث جوزنا التأخير في ذلك وفي النذور مدة العمر فإن حكمنا بأنه لا يعصى إذا مات لم يتحقق معنى الوجوب وإن قلنا يضيق عليه عند الانتهاء إلى غاية معينة من غير دليل لزم تكليف ما لا يطاق كذا في المحصول قال فلم يبق إلا أن نقول يجوز له التأخير بشرط أن يغلب على ظنه أنه يبقى سواء بقي أم لا وإذا ظنه أنه لايبقى عصى بالتأخير سواء مات أم لا وهذا الذي قاله قول والصحيح أنه إذا مات عصى سواء غلب على ظنه قبل ذلك البقاء أم لا ولا يلزم التكليف بما لا يطاق لأنه كان يمكنه المبادرة فالتمكن موجود وجواز التأخير بشرط سلامة العاقبة وتبين خلافه فتبين عدم الجواز
والوجوب تحقق مع التمكن فيقضى والفرق بينه وبين ما إذا مات في أثناء وقت الصلاة فإنه لا يعصى على الصحيح بأن الموت خرج وقت الحج وبالموت في أثناء وقت الصلاة لم يخرج وقتها ونظير الحج أن يفوت آخر وقت الصلاة فإنه يعصى بخروج الوقت وقول المصنف فله التأخير على رأي الإمام ظاهرا وباطنا وعلى رأينا ظاهرا فقط والباطن مجهول الحال ولا يلزم تكليف ما لا يطاق لما قلناه
وقوله ما لم يتوقع يعني فواته يعني فلا يجوز التأخير كما قدمناه عن الإمام وعبارة الإمام إذا غلب ظنه وهو صحيح وأما التوقع فلا يلزم منه الظن بل قد يحصل خوف فقط من غير غلبة ظن كما قدمناه في الكلام على الواجب المخير والمرتب فكان الصواب أن يقول المصنف ما لم يظن فواته وإن أخر وهي الحالة التي قدمها في الصلاة أنه إذا غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه فصار الموسع بالعمر يعصى فيه شيئين
أحدهما الموت على الصحيح
والثاني التأخير عن وقت يظن فوته بعده والموسع بما دون العمر يعصى فيه لشيئين
أحدهما خروج وقته
والثاني تأخيره عن وقت يظن فوته بعده كالموسع بالعمر ومن القضاء ما لا يجوز تأخيره مدة العمر كقضاء رمضان لا يجوز تأخيره حتى يجيء رمضان آخر فهو بالنسبة إلى المعصية بالتأخير كالصلاة وبالنسبة إلى عدم فواته كالحج
المسألة الثالثة في الواجب العيني والواجب الكفائي
الثالثة الوجوب إن تناول كل واحد كالصلوات الخمس أو أحدا معينا كالتهجد فيسمى فرض عين أو غير معين كالجهاد يسمى فرضا على الكفاية فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط عن الكل وإن ظن أنه لم يفعل وجب قيل إن الوجوب على الكفاية مخالف بالحقيقة للوجوب على الأعيان وأن اسم الوجوب صادق عليهما بالاشتراك المعنوي وزعم بعضهم أن المخاطب بفرض الكفاية طائفة لا بعينها وهو ظاهر قوله تعالى ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والصحيح أن المخاطب به الجميع لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب المعين بالشيء المجهول فإنه يمكن كالكفارة وإنما يفترق فرض الكفاية وفرض العين في أن فرض الكفاية المقصود منه تحصيل مصلحته من غير نظر إلى فاعله وفي تحقيقه ثلاثة معانأحدها أن كل مكلف يخاطب بالجهاد مثلا فإن قام به طائفة سقط عن الباقين رخصة وتخفيفا ولحصول المقصود
والثاني أن كل مكلف مخاطب به إن لم يقم غيره به وعلى هذا إذا قام غيره به تبين أنه لم يكن مخاطبا ليس أنه خوطب ثم سقط
والثالث أن كل مكلف غير مخاطب به ومجموعهم مخاطبون بأن يكون من بينهم طائفة تقوم بهذا الفعل ولا يقال يلزم أن يكون الشخص مكلفا بفعل غيره لأنا نقول كلفوا بما هو أعم من فعلهم وفعل غيرهم وذلك مقدور تحصيله منهم ولأنهم قادرون أن يخرجوا طائفة منهم لذلك وفرض العين المقصود منه
امتحان كل واحد بما خوطب به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه لا يقوم غيره مقامه وقد يكون من فرائض الأعيان على جماعة ما يشترط في فعل غيره كالجمعة لا تصح إلا من جماعة وصارت الواجبات ثلاثة
أحدها ما يجب على الشخص ويسقط بفعل غيره وهو فرض الكفاية
والثاني ما لا يعتبر معه غيره أصلا
والثالث ما يعتبر في الأداء وكلاهما فرض العين ولا يسقط بفعل الغير
إذا عرفت هذا فنقول إن قوله إن تناول كل واحد فيسمى فرض عين لك أن تعترض عليه فيه لما علمت أن فرض الكفاية كذلك على الصحيح وتعتذر عنه بأنه استغنى بالمثال بالصلوات الخمس
وقوله أو واحدا معينا كالتهجد قاله جماعة غيره وهو تفريغ على أن التهجد كان واجبا على النبي صلى الله عليه و سلم وحده وأن ذلك من خصائصه وهذا وإن كان مشهورا عند أكثر المتأخرين من الشافعية فالصحيح الذي نص عليه الشافعي خلافه وأن وجوب التهجد منسوخ عنه صلى الله عليه و سلم وعن غيره وحين كان واجبا كان عليه وعلى غيره وقد اختص النبي صلى الله عليه و سلم بوجوب أشياء لا خلاف فيها منها التخيير لنسائه وغيره وقوله أو غير معين إنما يتم عند من يرى أن فرض الكفاية ليس على الجميع وقد بينا أن الصحيح خلافه
ثم إن كل ما يتناول المعين يتناول غير المعين لدخوله في المعين فالعبارة المحررة أن تقول ويراد بالقصد ما قدمناه من مقصود فرض الكفاية أما إذا أريد معنى خوطب فلا يصح أيضا لما بينا أن الخطاب فيهما للجميع وقوله فإن ظن إلى آخره قاله الإمام مستدلا بأن تحصيل العلم بأن الغير هل فعل أولا غير ممكن إنما الممكن تحصيل الظن ولك أن تقول الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم وليس فيه تكلف بما لا يمكن لأن الفعل يمكن فيه حصول العلم ثم قولهم إنه يسقط بفعل البعض يوهم أن فعل غيرهم بعد ذلك يقع نفلا وليس كذلك فإن كل من جاهد أو طلب يقع فعله
فرضا وإن كان فيمن سبقه كفاية وكذا إذا صلى على الجنازة ظائفة ثم طائفة وقع فعل الثانية فرضا كالأولى هذا تحقيق أن الخطاب للجميع وإنما يسقط الإثم بفعل من فيه كفاية رخصة وتخفيفا
وقول المصنف فإن ظن كل طائفة أن غيره إما أن يكون ذكر على لفظ كل أو على معنى طائفة وأنها تطلق على الواحد فإن كان الأول فالذي أجمع عليه النحاة أن لفظ كل إذا أضيف إلى نكرة وجب مراعاة المضاف إليه وإن كان الثاني فالحق أن معنى طائفة لا يكون للواحد لأنها مأخوذة من معنى الطواف والإحاطة وذلك لا يكون بالواحد ولو سلم صدقها على الواحد فلا اختصاص فيه بل يصدق على الجمع كما يصدق على الواحد فلا وجه للتذكير إلا إذا أريد الواحد وليس هو المراد هنا فكان التأنيث في هذا المكان أولى
المسألة الرابعة في مقدمة الواجب
الرابعة وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا قوله مطلقا احتراز من الوجوب المقيد بشرط كالزكاة وجوبها متوقف على النصاب ولا يجب تحصيله وجوبها متوقف على الجماعة والإقامة ولا يجب تحصيلهما وهذا متفق عليه وقوله وكان مقدورا احتراز من قدرة العبد على الفعل وداعيته المخلوقتين لله تعالى لا تتم الواجبات المطلقة عليه وغيرها إلا بهما ولا يجب تحصيلهما ولا يتوقف الوجوب عليهما وجملة ما يتوقف عليه الفعل إما أن يكون من فعل الله أو فعل العبد وكل منهما إما أن يتوقف عليه الوجوب أو لا فالذي من فعل الله يتوقف عليه الوجوب كالعقل وسلامة الأعضاء التي بها الفعل والذي لا يتوقف عليه الوجوب كخلق قدرة العبد وداعيته والذي من فعل العبد ويتوقف عليه الوجوب كما سبق والذي لا يتوقف عليه الوجوب إما أن يكون مقدورا أو لا فغير المقدور لا يتحقق معه وجوب الفعل إلا على القول بتكليف ما لا يطاق وحينئذ يصح وجوب غير المقدور مما يتوقف عليه الواجب فلا يصح اشتراط كونه مقدورا لذلك لم أر مثالا يصح اجتماع الوجوب معه إلا القدرة الداعية ورأيت جماعة خبطوا في ذلك وقولنا ما لا يتم الشيء إلا به يشمل بالوضع ثلاثة أشياء الجزء والسبب والشرط لكن الجزء ليس مرادا هنا لأن الأمر بالكل أمر به تضمنا ولا تردد في ذلك وإنما المراد السبب والشرط وأن الأمر بالشيء هل يستلزم الأمر بسببه أو شرطه أو لا ولذلك عبر بعضهم بالمقدمة والمقدمة خارجة عن الشيء مقدمة عليه بخلاف الجزء فإنه داخل فيه والمختار وجوب السبب والشرط كما ذكر المصنفوالجزء إذا لم يكن مقدورا سقط وجوبه إذا لم نقل بتكليف ما لا يطاق من
ضرورة ذلك عدم وجوب الكل حينئذ لكن بقي وجوب ما سواه من الأجزاء لقوله صلى الله عليه و سلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
وهذا آخر ما كتبه الشيخ الإمام العلامة المجتهد شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين بقية المجتهدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي رحمه الله ورحم أموات المسلمين وتممه ولده قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب فسح الله في مدته ونفع به آمين
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين رب يسر قال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العلامة الأوحد البارع الحافظ شيخ الإسلام مفتي الأنام قدوة الأئمة حبر الأمة ناصر السنة قامع البدعة علامة العلماء وارث الأنبياء فريد دهره ووحيد عصره قاضي القضاة تاج الدين ابت سيدنا ومولانا قاضي القضاة أوحد العلماء العاملين آخر المجتهدين تقي الدين أبي الحسن السبكي الشافعي متع الله بحياته المسلمين وأيده وأمده بعونه وأدام النفع به آمين
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل لنا من هذا الدين القيم شرعة ومنهاجا و وأطلع لنا في سماء العلم الشريف من الكتاب والسنة سراجا وهاجا وقدر للفقيه أن يكون على الإجماع محتالا وإلى القياس محتاجا نحمده على نعمه التي خصنا بعمومها ورجحنا على من سوانا بأدلة مفهومها واستوعب لنا ما وجد منها عند سبرها وتقسيمها ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة ظاهرة غير مؤولة دائمة نستصحب أحكاما غير مبدلة نامية الثواب يوم المعاد فلا يحتاج إلى بيان أحكامها المجملة ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي نسخ شرع من قبله بشرعه المؤيد وأمر ونهى فأوجب وندب وحرم وأباح وأطلق وقيد واجتهد في إبلاغ ما أمر به فذب العقل عن فعل ما قرره وشيد صلى الله عليه و سلم وعلى آله وأصحابه الذين فهموا خطاب وضعه وقاموا بشرائط دينه وعلموا أدلة شرعه واتبعوه فما منهم إلا من قال بموجب أصله وفرعه صلاة تصل أخبارها إليهم بكرة وعشيا وتفد أجناسها المتنوعة بفصولها المتميزة عليهم فتسلك صراطا سويا وتخلص فتخلص قائلها من الأهوال يوم يموت ويوم يبعث حيا دائمة ما افتقر فرع إلى الرجوع إلى أصله واحتاج المجادل إلى تجويد نصه كما يحتاج المجالد إلى تجريد نصله باقية لا ينعكس طردها ولا يشتبه محكمها
بترهات الملحد وزخرف قوله ورضى الله عن التابعين لهم بإحسان المقتفين آثارهم الحسان وخص بمزيد الرضوان العلماء الحامين حمى الشريعة أن يضام أو يضاع الوارثين بالدرجة الرفيعة هدى النبوة الذي لا يرام ولا يراع الوافدين على حياطته بالهمة الشريفة حتى لا ينفك أو يشان ويشاع لا سيما الإمام المطلبي مستخرج علم أصول الفقه محمد بن إدريس الشافعي الذي ساد المجتهدين بما أصل وأنشأ وسار نبأ مجده والبرق وراءه يتحرق عجله وهو أمامه على مهل يتمشى وساق إلى سواء السبيل بعلومه التي غشاها من تقوى الله ما غشى وقدس أرواح أصحابه الذين زينوا أسماء العلوم من أنفسهم بزينة الكواكب وهاموا باتباع مذهبه المذهب وللناس فيما يعشقون مذاهب
وذادوا عن بيان ما أجمله وإيضاح ما أشكله والعلوم عطايا من الله ومواهب رضا يتكفل بنجاة كل منهم ونجاحه ويمر بروض الإيمان فيتعطر بأنفاسه رياحه ويفخر عقد الجوزاء إذا كان درة في وشاحه
أما بعد فإن العلوم وإن كانت تتعالى شرفا وتطلع في افق الفخار من كواكبها شرفا فلا مرية في أن الفقه نتيجة مقدماتها وغاية نهاياتها وواسطة عقدها ورابطة حلها وعقدها به يعرف الحرام من الحلال وتستبين مصابيح الهدى من ظلام الضلال وهيهات أن يتوصل طالب وإن جد المسير إليه أو يتحصل بعد الإعيا والنصب عليه إلا بعد العلم بأصول الفقه والمعرفة والنهاية فيه فإنه صفته وكيف يفارق الموصوف الصفة وقد نظرنا فلم نر مختصرا أعذب لفظا وأسهل حفظا وأجدر بالاعتناء وأجمع لمجامع الثناء من كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للشيخ الإمام العالم العلامة قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي بيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وروض تربته بغمام الغفران حتى يأتي يوم القيامة وما ثلم جانبه ولا فض فوه فإنه موضوع على أحسن منهاج محمول على الأعين وليس له منها من هاج بعبارة أعذب من ماء السحاب وألعب من ابنة الكرم بعقول أولي الألباب آل فضل البلاغة إليه وآلى فضل الخطاب ألا يتمثل إلا بين يديه وقد رأيت شراحه على كثرتهم مالوا إلى الإيجاز وقالوا وكأنما ضاق بهم الفضاء الواسع فعد مقالهم
في الألغاز قنع كل منهم بحاجة في نفسه من اسم التصنيف قضاها وجمع نفسه على ما شف به سجل الكتاب من تقارير إذ أنصف من نفسه لا يرضاها فشروحهم تحتاج إلى من يشرحها وكلماتهم تريد بسطة في العلم والجسم توضحها
وقد كان الشيخ الإمام والدي رحمه الله شرع في وضع شرح عليه أبهى وأبهج من الوشي المرقوم وأسرى وأسرع إلى الهداية من طوالع النجوم عديد شهب لائحه ورسل سحب سائحه وسماه علم يهتدى بكوكبه وعلاء قدر أخذ بلمة الفخر ولم يزاحمه بمنكبه لا تنقشع عارضته ولا نتوقع معارضته خضعت رقاب المعاني لكلامه وخشعت الأصوات وقد رأته جاوز الجوزاء وما رضيها دار مقامه لكنه أحسن الله إليه ما غاص في بحره إلى القرار ولا أوصل هلاله إلى ليلة البدار بل أضرب عنه صفحا بعد لأي قريب وتركه طرحا وهو الدر اليتيم بين إخوانه كالغريب وقد حدثتني النفس بالتذييل على هذه القطعة وأحاديث النفس كثيرة وأمرتني الأمارة بالتكميل عليها ولكني استصغرتها عن هذه الكبيرة وقلت للقلم أين تذهب وللفكر أين تجول أطنب لسانك أم أسهب ووقفت وقفة العاجز والنفس تأبى إلا المبادرة بما به أشارت وجرت على تيارها منادية أئت بما أمرتك بما استطعت وتوارى اللسان وما توارت فلما تعارض المانع والمقتضى وعلمت أن الحال إذا حاولت مجهودها قام لها العذر الواضح فيما استقبلته ومضى أي مضى أعلمت الفكرة في الدجنة والوجه والليل كلاهما كالح وشرعت فيه وقلت لعل الغرض يتم ببركته وبقصده الصالح وجردت همة ما ورد رائدها إلا وقد سئم من النشاط ولا أغمد مهندها إلا وقد ترك ألف طريح على البساط ولا عاد نصلها إلا وقد قضى المأمول ولا فترت عزائمها إلا وقد حصلت على نهاية السول وأعلمنا هذه الهمة في مدلهم الديجور وصرفنا قلمها بشهادة النجوم وفلكها يدور فلم تنشب ليالي أسبلت جلبابها وأرخت نقابها معدودة ساعاتها ممدودة بالألطاف الخفية أوقاتها إلى أن انهزمت تلك الليالي ودارت الدائرة عليها وجاء من النسيم العليل بشير الصبح متقدما بين يديها فوافى الصباح بكل معنى مبتكر وجلا عرائس بدائعه فشنف السمع وشرف البصر وجاء كتابا ساطعا نور شمسه وشمس السماء في غروب طالعا
في أفق الفخار على أحسن أسلوب جائزا لما يراد منه في كل طريقه جائزا حقا على مقالات المتقدمين والمتأخرين وحسبك بمن مجازه حقيقة فأسأل الله تعالى أن يعم النفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه وقد وصل والدي الشيخ الإمام جزاه الله الخير إلى مسألة مقدمة الواجب ونحن نتلوه والله الموفق المعين بخفي ألطافه والمحقق لرجاء العبد بإسعاده وإسعافه
قال المصنف رحمه الله
الرابعة وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم الا به وكان مقدوراقال والدي تغمده الله برحمته قوله مطلقا احتراز من الوجوب المقيد كشرط الزكاة وجوبها متوقف على النصاب ولا يجب تحصيله والجمعة وجوبها متوقف على الجماعة والاقامة في بلد ولا يجب تحصيلهما وهذا متفق عليه وقوله وكان مقدورا احتراز من قدرة العبد على الفعل وداعيته المخلوقتين لله تعالى لا تتم الواجبات المطلقة عليه كالصلاة وغيرها إلا بهما ولا يجب تحصيلهما ولا يتوقف الوجوب عليهما وجملة ما يتوقف عليه الفعل اما أن يكون من فعل الله تعالى أو فعل العبد وكل منهما اما أن يتوقف عليه الوجوب اولا فالذي من فعل الله تعالى ويتوقف عليه الوجوب كالعقل وسلامة الاعضاء التي بها الفعل والذي لا يتوقف عليه الوجوب خلق قدرة العبد وداعيته والذي من فعل العبد ويتوقف عليه الوجوب اما أن يكون مقدورا أولا فغير المقدور لا يتحقق معه وجوب الفعل الا على القول بتكليف ما لا يطاق وحينئذ يصح وجوب غير المقدور مما يتوقف عليه الواجب فلا يصح اشتراط كونه مقدورا فلذلك لم أر مثالا يصح اجتماع الوجوب معه الا القدرة والداعية ورأيت جماعة خطبوا في ذلك
وقولنا ما لا يتم الشيء الا به يشمل بالوضع ثلاثة أشياء الجزء والسبب والشرط لكن الجزء ليس مرادا هنا لأن الأمر بالكل أمر به تضمنا ولا تردد في ذلك وانما المراد السبب والشرط وأن الأمر بالشيء هل يستلزم الأمر بسببه أو شرطه أو لا ولذلك عبر بعضهم عنه بالمقدمة والمقدمة خارجة عن الشيء
متقدمة عليه بخلاف الجزء فانه داخل فيه والمختار وجوب السبب والشرط كما ذكره المصنف والجزء إذا لم يكن مقدورا سقط وجوبه إذا لم نقل بتكليف ما لا يطاق ومن ضرورة ذلك عدم وجوب الكل حينئذ لكن يبقى وجوب ما سواه من الأجزاء لقوله صلى الله عليه و سلم
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
قلت هذا ما وقف عنده والدي الشيخ الامام تغمده الله برحمته و رضوانه ومن هنا أبتدئ وبالله التوفيق فأقول لا مزيد على حسن ما ذكره وأما قوله إذا لم يجب الكل لعدم القدرة على الجزء يبقى وجوب ما سواه من الأجزاء فصحيح ومستنده الحديث الذي أورده وهو القاعدة التي يذكرها الفقهاء الميسور لا يسقط بالمعسور وسنلتفت ان شاء الله في ذيل المسألة اليها
قال قيل يوجب السبب دون الشرط وقيل لا فيهما
عرفت المذهب المختار وقال قوم يوجب السبب ولا يوجب الشرط سواء كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة أو عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه وقيل لا يوجبه مطلقا هذه المذاهب التي حكاها المصنف وفي المسألة مذهب رابع ارتضاه امام الحرمين واختار ابن الحاجب أن وجوب الشيء مطلقا يوجب الشرط الشرعي دون العقلي أو العادي
قال لنا أن التكليف بالمشروط دون محال قيل يختص بوقت وجود
الشرط قلنا خلاف الظاهر قيل ايجاب المقدمة أيضا كذلك قلنا لا فان اللفظ لم يدفعه
لما اشترك المذهبان اللذان حكاهما آنفا في عدم ايجاب الشرط رد عليهما بالدليل المذكور وقوله التكليف بالمشروط دون الشرط هذه العبارة تحتمل ثلاثة معان
أحدهما التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط ونقرر استحالته بأنه إذا لم يجب الشرط جاز تركه فنقدر هذا الجائز واقعا فيصير واقعا كالمعنى الثاني وسنقرر ان شاء الله استحالته ولكن هذا المعنى ليس مراده لأنه محل النزاع فلو أراده لكان مصادرا على المطلوب ولأنه يحوج الى اضمار ولأن قوله بعد ذلك قيل يختص بوجود الشرط يرشد الى خلافه ولأن الامام صرح بالمقصود فقال حال عدم المقدمة
المعنى الثاني أن يكون التكليف حال عدم الشرط وهذا هو المقصود وهو على قسمين أيضا
أحدهما وهو الثاني من المعاني يكلف وقت عدم الشرط بايقاع المشروط حينئذ ولا شك أن هذا تكليف بما لا يطاق والاستحالة جاءت من تضاد متعلق التكليف ووقته لا من خصوصه ولا من خصوص وقته وقريب من هذه العبارة أن يختص التكليف بوقت عدم الشرط
والثاني من القسمين وهو الثالث من المعاني أن يكلف وقت عدم الشرط بايقاع المشروط مطلقا ومقتضى ذلك ألا يختص التكليف بوقت بل يوجد حال وجود الشرط وعدمه والمكلف به في القسمين المشروط من حيث هو لا بقيد الشرط ولا بقيد عدمه والتقييد يقيد عدمه مستحيل في نفسه ويقيد وجوده يلزم منه طلب الشرط كما هو المدعى أعني إذا كان المطلوب المشروط ووقت طلبه غير مقيد
إذا عرفت ذلك فنقول لو لم يوجب ايجاب الشيء مطلقا ما يتوقف عليه ذلك الشيء لكنا قد كلفنا بالمشروط من غير التكليف بالشرط وهو تكليف
بمحال لأنه إذا كان المشروط مكلفا به دون الشرط لم يحبب الإتيان بالشرط وإذا جاز ترك الشرط لزم منه جواز ترك المشروط لأن انتفاء الشرط مستلزم لانتفاء المشروط فيلزم كون المشروط جائز الترك واجب الفعل وهو تكليف بما يلزم من المحال فتعين أن يكون التكليف بالمشروط موجبا للتكليف بالشرط وإن أثبت ذلك في الشرط ففي السبب بطريق أولى فإن من قال بوجوب الشرط قال بوجوب السبب من غير عكس
هذا تقرير الدليل وقول المصنف التكليف بالمشروط دون الشرط محال فيه نظر لأنا نفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال فالأول هو تكليف العاقل الذي يفهم الخطاب بما لايطيقه وهو محل الخلاف في تكليف ما لا يطاق لأن المخاطب به يعلم أنه مكلف بذلك
والثاني مثل تكليف الميت والجماد ومن لا يعقل من الأحياء فهذا تكليف المحال واتفق أهل الحق قاطبة على أنه لا يصح نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر رحمه الله فكان الأحسن للمصنف أن يقول تكليف محال كما قررناه وعذره في ذلك أنه فرع على تكليف ما لا يطاق فإن الأصحاب وإن أقروا بتكليف ما لا يطاق في موضعه لا يفرعون عليه ويحيلون ما لزم عنه لكونه غير واقع في الشريعة فحينئذ التكليف به محال عند المانعين منه فيصح كلامه
قوله قيل يختص بوقت وجود الشرط اعترض الخصم على الدليل المذكور بأنه لم لا يجوز أن يختص التكليف بالمشروط بحال وجود الشرط ولا امتناع في ذلك فإن غايته أن يقيد الأمر ببعض الأحوال لمقتض قام وهو الفرار من تكليف المحال وأجاب المصنف بأن اللفظ مطلق لا اختصاص له بوقت وجود الشرط خلاف الظاهر واعترض الخصم أيضا بأن ايجابكم المقدمة أيضا خلاف الظاهر لأن ظاهر الأمر لا يدل عليه فإذا جاز مخالفة الظاهر من هذا الوجه فلم لا يجوز من الوجه الذي ذكرناه وأجاب المصنف بأن مخالفة الظاهر عبارة عن إثبات ما ينفيه اللفظ أو نفي كا يثبته اللفظ ظاهرا وأما إثبات ما لم يتعرض اللفظ له بنفي ولا إثبات فليس مخالفة للظاهر وحينئذ لا يكون إيجاب المقدمة مخالفة للظاهر إذ لم يدل اللفظ عليه بنفي ولا إثبات بخلاف تخصيص
الأمر بوقت وجود الشرط فإن اللفظ يقتضي الوجوب مطلقا فتقييده بوقت وجود الشرط دون ما سواه مخالفة للظاهر فإن قلت كيف يكون حمل المطلق الصادق بصورة على أحد صوره خلاف الظاهر وليس فيه إثبات ما ينفيه اللفظ ولا نفي ما يثبته قلت لما اقتضى الإطلاق من كل صوره صار تقييده ه بصورة منافر لكونه مطلقا قال
تنبيه
مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة أو عقلا كالمشي للحج أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي وستر شيء من الركبة لستر الفخذعبر الإمام عن هذا بالفرع ووجهه أنه مندرج تحت أصل كلي ووجه التعبير عنه بالتنبيه أن الكلام السابق نبه عليه على سبيل الإجمال حاصله أن مقدمة الواجب تنقسم إلى أمرين
أحدهما أن يتوقف عليه وجوب الواجب وهو نوعان
أحدهما أن يتوقف عليه شرعا كالوضوء مع الصلاة
الثاني أن يتوقف عليه عقلا كالسير إلى الحج وعبارة المصنف المشي وقد يناقش فيها والأمر سهل
القسم الثاني أن يتوقف عليها العلم بوجود الواجب لا نفس وجود الواجب فلذلك إما لالتباس الواجب بغيره كالإتيان بالصلوات الخمس إذا ترك واحدة ونسي عينها فإن العلم بأنه أتى بالصلاة المنسية لا يحصل إلا بالإتيان بالخمس وإما أن يكون لتقارب ما بين الواجب وغيره بحيث لا يظهر حد مفرق بينهما وذلك كستر شيء من الركبة لستر الفخذ فإن الفخذ والركبة متقاربان فالعلم بستر جميع الفخذ الذي هو واجب إنما يحصل بستر شيء من الركبة للتقارب المذكور هذا ما ذكره وهو مبني على أن الفخذ نفسه عورة وذلك في المرأة بلا خلاف وفي الرجل على الصحيح وعلى أن الركبة نفسها ليست بعورة وهو الصحيح أيضا فإن قلت القول بإيجاب الخمس على من نسي
أحدها وجهل عينها عند من يوجب المقدمة واضح وأما من لايوجبها فماذا يفعل وما فائدة الخلاف قلت قد لا ينظر الفقيه إلى الخلاف الأصولي في كثير من الفروع ولا يجعل لها به تعلقا البتة وقد يقال بظهور فائدة الخلاف في أنه هل يصلي الخمس بتيمم واحد أو بخمس تيممات لكن الصحيح إيجاب تيمم واحد وقضية القول بوجوب المقدمة إيجاب خمس تيممات فإن قلت ما وجه القصور في الإيجاب على تيمم واحد والخمس فرائض ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة قلت الأربعة من حيث إنها لم ترد لنفسها منحطة عن مراتب الفرائض ولذلك قيل صلاة ركعتين تطوعا أفضل من إحدى الصلوات الأربع التي هي غير واجبة في نفس الأمر وعد ذلك موضعا يفضل الندب فيه الواجب ونحن لنا في هذا نظر ليس هذا موضعه
فروع فقهية
قال فروع الأول لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا على معنى أنه يجب عليه الكف عنهماأما الأجنبية فواضح وأما المنكوحة فلاشتباهها بالأجنبية فالكف عنهما هو طريق حصول العلم بالكف عن الأجنبية وإنما قال على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما لأن الحرام عليه في نفس الأمر هي الأجنبية فقط فمعنى تحريمهما عليه وجوب الكف عنهما فنبه عليه واعلم أن هذا النوع في الحرمة لما لا يتم الواجب إلا به شبيه في الوجوب للإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي عينها
قال الثاني إذا قال إحداكما طالق حرمتنا تغليبا للحرمة والله تعالى يعلم أن سيعين إحداهما لكن ما لم يعين لم تتعين
إذا قال إحداكما طالق ولم ينو إحداهما على التعيين حرمت الزوجتان عليه إلى حين التعيين لأن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المطلقة فتحرم أو غير المطلقة فلا تحرم وإذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام والفرق بين هذا والذي قبله أن إحدى المرأتين في الصورة الأولى ليست محرمة بطريق الأصالة
بل للاشتباه بخلاف الفرع الثاني فإنهما في ذلك سواء وأيضا فالزوج غير قادر على إزالة التحريم في الأول دون الثاني وهذا الذي جزم به المصنف حكاه الإمام مذهبا لبعضهم وقال يحتمل أن يقال يحل وطؤها لأن الطلاق شيء معين فلا يحصل إلا في محل معين فقبل التعيين لا يكون الطلاق نازلا في واحدة منهن ويكون الموجود قبل التعيين ليس هو الطلاق بل أمر له صلاحية التأثير في الطلاق عند اتصال البيان به لا إنه طلاق وإذا لم يوجد الطلاق قبل التعيين وكان الحل موجودا أوجب القول لبقائه فيحل وطؤها معا معا هذا كلامه ونقل ابن رفعة عن كتاب الوزير ابن هبيرة الذي حكى فيه ما اجتمع عليه الأئمة الأربعة وما اختلفوا فيه أن ابن هبيرة من أصحابنا قال إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها أو بعينها ثم أنسيها طلاقا رجعيا أنه لا يحال بينه وبين وطئهن وله وطء أيتهن شاء وإذا وطيء واحدة انصرف الطلاق إلى صاحبتها وهذا يعضد ما حاوله الإمام وهو ضعيف لأنا نقول محل الطلاق القدر المشترك بينهما وهو إحداهما لا بعينه وهو متعين بالنوع وإن لم يكن متعينا بالشخص واستدعاء الطلاق من حيث كونه وصفا متعينا محلا معينا يكفي فيه التعيين بالنوع
سلمنا أنه يقتضي تعينا بالشخص ولكن نقول هو عند الله متعين
بالشخص ونحن في الخارج لا نعلمه حتى يعينه العبد بالطلاق النازل لوجوده من قادر على التصرف في محل قابل فينفذ ولا نفوذ له إلا بوقوعه في الخارج منجزا لأنه كذلك أوقعه فلو لم يقع كما أوقعه لما نفذ التصرف ولكن لا نحكم ببطلان الزوجية إلا من حين علمنا بذلك الشخص الذي كان مبهما علينا ولا ينعطف على ما مضى لجهلنا في الماضي بالحال
قوله والله تعالى يعلم أنه سيعين جواب عن سؤال مقدر ويمكن أن يقرر على وجهين
أحدهما إن الله تعالى يعلم المرأة التي سيعينها الزوج بعينها فتكون هي المطلقة في علم الله تعالى وإنما هو مشتبه علينا وهذا سؤال أورده الإمام على نفسه في قوله بالإباحة فإن الاشتباه يقتضي التحريم وهو خلاف ما مال إليه وجوابه أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه فلا يعلم غير المعين معينا لأن ذلك جهل وهو محال في حق الله تعالى بل علمه في الحال بأنه سيعين في المستقبل وهذا التقرير ماش على ما في المحصول إلا أنه يلزم منه أن يكون المصنف أورد سؤالا على دعوى لم يدعها ولم يذكرها البتة وهي القول بالإباحة
والثاني أن يقال لا فارق هذا الفرع والفرع الذي قبله إلا أن إحدى المرأتين في ذلك وهي الأجنبية محرمة في نفس الأمر وكل واحدة منهما هنا على حد سواء ونحن لا نسلم أن كل واحدة منهما محتملة الحل والحرمة حتى يحصل ما ذكرت بل الله يعلم المحرمة فهي معينة في علمه تعالى فلا فرق لتعيين المحرمة في نفس الأمر كونها يقع عليها الطلاق لا كونها مطلقة الآن لما عرفته وهذا التقرير لا معترض فيه على المصنف إلا أنه مع التعسف مخالف لما في المحصول
قال الثالث الزائد على ما ينطلق عليه الإسم من المسح غير واجب وإلا لم يجز تركه وجه تفريغ هذا على مقدمة الواجب أنه لما كان الواجب لا ينفك غالبا عن حصول زيادة فيه كانت هذه الزيادة مقدمة للعلم بحصول الواجب وقد أورد على المصنف أنه إذا كان الزائدد عنده مقدمة الواجب فيلزم أن يحكم
عليه بالوجوب كستر شيء من الركبة وأجيب عنه بأن مراده بالمقدمة هناك غير القسم الذي يكون التوقيف فيه من حيث الإعادة إذا عرفت هذا فنقول الواجب إما أن يتقدر بقدر كغسل الرجلين واليدين ولا كلام فيه أولا كمسح الرأس وكإخراج البعير عن الشاة الواجبة في الزكاة وكذبح المتمتع بدنه بدل الشاة وحلقه جميع الرأس وتطويل أركان الصلاة زيادة على ما يجوز الاختصار عليه والبدنة المضحى بها بدلا عن الشاة المنذورة فنقول اختلفوا في القدر الزائد على الذي يعاقب على تركه وهو في أمثلتنا ما يعد أقل ما ينطلق عليه الاسم من المسح وقدر قيمة الشاة من البعير والبدنة وفوق الشعرات الثلاث في الحلق وفوق قدر الوجوب في الطمأنينة هل يوصف بالوجوب فذهب الإمام وأتباعه ومنهم المصنف إلى أنه لا يوصف بذلك لأن الواجب لا يجوز تركه وهذه الزيادة جائزة الترك وقال آخرون يوصف بالوجوب لأنه إذا زاد على القدر الذي يسقط به الفرض لا يتميز جزء عن جزؤ لسقوط الفرض به لصلاحية كل جزء لذلك فتخصيص بعض الأجزاء بوصف الواجب ترجيح من غير مرجح
فإن قلت ما محل الخلاف في مسح الرأس هل هو ما إذا وقع الجميع دفعة واحدة حتى إذا وقع مرتبا يكون الزائد نفلا جزما أم هو جار في الصورتين
قلت للأصحاب في ذلك وجهان فإن قلت ما فائدة الخلاف في هذه الصورة
قلت
منها الثواب فإن ثواب الفريضة أكثر من ثواب النافلة بسبعين درجة كما حكى النووي عن إمام الحرمين
ومنها إذا عجل البعير عن شاة واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع بجميعه أم بسبعة وفيه وجهان في شرح المهذب
ومنها لو أخرج بعيرا عن عشر من الإبل أو خمسة عشر أو عشرين هل يجزيه فيه وجهان مبنيان على هذا الخلاف إن قلنا بوقوعه كله فرضا فيما إذا أخرجه عن الخمس فلا يكفي بعير واحد بل لا بد في العشرة من بعيرين أو بعير وشاة وهكذا وإن قلنا الفرض قدر خمسة فيجزئ ويكون متبرعا في العشرة بثلاثة أخماس على أن إمام الحرمين وغيره أنكروا هذا البناء وليس هذا محل القول فيه
واعلم أنه يضاهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب صور في الفقه منها مؤونة الكيل الذي يفتقر إليه القبض على البائع كمؤونة إحضار المبيع الغائب ومؤونة وزن الثمن على المشتري وفي أجرة نقد الثمن وجهان
ومنها إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن غسله كله
ومنها إذا اكترى دابة للركوب فأطلق الاكتراء أن على المكري الإكاف والبرذعة والحزام وما ناسب ذلك لأنه لا يتمكن من الركوب دونها وهي صور عديدة من أراد الإحاطة فعليه بكتابنا الاشباه والنظائر أتمه الله تعالى وقد كنا في أول المسألة وعدنا بالالتفات إلى قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور والصور تحتها كثيرة ونحن نحيل طالبها بعد ذكر القليل منها على كتابنا المذكور
فمنها لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنعه الانحناء لزم القيام خلافا لأبي حنيفة
ومنها لو لم يقدر على الانتصاب بأن تقوس ظهره لكبر أو زمانة فصار في حد الراكعين فقد قال الغزالي تبعا لإمامه أن يقعد وقال غيرهما لا يجوز له
القعود فإن الوقوف راكعا أقرب إلى القيام من القعود فلا ينزل عن الدرجة القربى إلى البعدى
ومنها لو وجد الجنب من الماء ما لا يكفيه لغسله أو المحدث ما لايكفيه لوضوئه فأصح القولين أن يجب استعماله ثم يتيمم لأن القدرة على البعض لا تسقط بالعجز عن الباقي
ومنها لو اطلع على عيب البيع ولم يتيسر له المبادرة بالرد ولا الإشهاد ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان هنا وفي الشفعة
ومنها لو لم يفضل معه في الفطرة عما لا يجب عليه إلا بعض صاع لزمه إخراجه على الأصح
ومنها إذا اشترى الشقص بثمن مؤجل فهل يأخذه الشفيع مؤجلا كما أشتراه المشتري وأصح الأقوال أن الشفيع بالخيار بين أن يعجل ويأخذ الشقص في الحال وبين الصبر إلى حيلولة الأجل وعلى هذا فهل يجب تنبيه المشتري على الطلب وجهان
ومنها إذا كان يحسن آية فلا خلاف أنه يقرؤها وهل يضيف إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة أو يكررها سبعا فيه قولان
فإن قلت لم لا جرى قول أنه لا يقرأ تلك الآية بل يأتي ببدل الفاتحة كلها كما إذا قدر على بعض وضوئه ونظائره
قلت كل آية من الفاتحة يجب قراءتها بنفسها فلا يأتي ببدلها مع القدرة عليها والله أعلم
المسألة الخامسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه
قال الخامسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنها جزؤه فالدال عليه يدل عليها بالتضمن قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه قلنا لا فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه محال وإن سلم فمنقوض بوجوب المقدمةهذه هي المسألة المعروفة بأن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده
أعلم أنه لا نزاع في أن الأمر بالشيء نهي عن تركه بطريق التضمن وإنما احتلفوا في انه هل هو نهي عن ضده الوجودي على مذاهب
أحدها أن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده
والثاني أنه غيره ولكن يدل عليه بالالتزام وهو رأي الجمهور منهم الإمام وصاحب الكتاب وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لانتفاء حصول المقصود إلا بانتفاء كل ضد والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده لحصول المقصود بفعل ضد واحد فالأولى التعبير بهذه العبارة وبها صرح إمام الحرمين
والثالث أنه لا يدل عليه أصلا ونقله في الكتاب عن المعتزلة وأكثر أصحابنا واختاره ابن الحاجب واستدل المصنف على اختياره بأن حرمة النقيض جزء من الوجوب لأن الواجب هو الذي يجوز فعله ويمتنع تركه وإذا كان كذلك فالدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن لأن المراد من دلالة التضمن أن اللفظ يدل على جزء ما وضع له والمراد بدلالة
الالتزام هنا دلالة اللفظ على كل ما يفهم منه غير المسمى سواء كان داخلا فيه أو خارجا عنه فيصدق قوله يدل بالتضمن مع قوله بالالتزام
واحتجت المعتزلة بأن الموجب للشيء قد يكون غافلا عن نقيضه فلا يكون النقيض منهيا عنه لأن النهي عن الشيء مشروط بتصوره وأجاب عنه بأنا لا نسلم أن الموجب للشيء قد يغفل عن نقيضه لأن الموجب للشيء ما لم يتصور الوجوب لا يحكم به ويلزم من تصور الوجوب تصور المنع من النقيض لأنه جزؤه وتصور الكل مستلزم لتصور الجزء ولو سلمنا أنه يجوز أن يكون الموجب للشيء قد يغفل عن نقيضه فذلك لا يمنع حرمة النقيض بدليل وجوب المقدمة أعني ما لا يتم الواجب إلا به فإن الموجب للشيء قد يكون غافلا عن مقدمته مع استلزام وجوبه لوجوبها كما تقدم هذا شرح ما في الكتاب
واعلم أنه قد تردد كلام الأصوليين في المراد من الأمر المذكور في هذه المسألة هل هو النفساني فيكون الأمر النفساني نهيا عن الضد نهيا نفسانيا أو اللساني فيكون نهيا عن الأضداد بطريق الالتزام وهذا هو الذي ذكره الإمام حيث صرح بلفظ الصيغة
وإذا عرفت هذا فنقول إن كان الكلام في النفساني تعين التفصيل بين من يعلم بالأضداد ومن لا يعلم فالله تعالى بكل شيء عليم وكلامه واحد وهو أمر ونهي وخبر فأمره عين نهيه وعين خبره غيرأن التعلقات تختلف فالأمر عين النهي باعتبار الصفة المتعلقة نفسها التي هي الكلام وهوغيره باعتبار أن الكلام إنما يصير أمرا بإضافة تعلق خاص وهو تعلق الكلام بترجيح طلب الفعل وإنما يصير نهيا بتعلقه بطلب الترك والكلام يقيد التعلق الخاص غيره بالتعلق الآخر فهذه الأقسام والتفاصيل لا ينبغي الخلاف فيها لمن تصورها وأن أمر الله تعالى بالشيء نهى عن ضده باعتبار أنه لا بد من حصول التعلق بالضد المنافي وأما من لا شعور له بضد المأمور فلا يتصور منه النهي عن جميع الأضداد بكلامه النفسي تفصيلا لعدم الشعور بها ولكن يصدق أنه نهى عنها بطريق الإجمال لأنه طالب للمأمور على التفصيل ولتحصيله بكل طريق مفض إلى ذلك ومن جملتها اجتناب الأضداد وإن كان في اللساني فلا يتجه
أن يقال الأمر تحرك ليست صيغة قولنا في الشيء نهي عن ضده فإن صيغته قولنا لا تسكن والمكابر في ذلك المنزل منزلة منكري المحسوسات وإنما يتجه الخلاف في أن صيغة الأمر هل دلت التزاما
وهذا الذي قررناه هو الذي اقتضاه كلام إمام الحرمين فإنه حكى اختلاف أصحابنا في أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به ثم قال وأما المعتزلة فالأمر عندهم هو العبارة وهو قول القائل أفعل أصوات منظومة معلومة وليس هي على نظم الأصوات في قول القائل لا تفعل ولا يمكنهم أن يقولوا الأمر هو النهي وهذا هو مقتضى كلامه في التخليص الذي اختصره من التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر فحصلنا من هذا على أن القائل بأن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده إنما كلامه في النفسي وأن المتكلمين في النفسي يقع اختلافهم على مذاهب
أحدها أن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده واتصافه بكونه أمرا نهيا بمثابة اتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من شيء بعيدا من غيره
والثاني وهو الذي مال إليه اختيار القاضي في آخر مصنفاته أنه ليس هو ولكن يتضمنه
الثالث أنه لا يدل عليه أصلا وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي ويتعين أن تكون هذه المذاهب في الكلام النفسي بالنسبة إلى المخلوق وأما الله تعالى فكلامه واحد كما عرفت لا يتطرق الغيرية إليه ولا يمكن أن يأمر بشيء إلا وهو مستحضر لجميع أضداده لعلمه بكل شيء بخلاف المخلوق فإنه يجوز أن يذهل ويغفل عن الضد وبهذا الذي قلناه صرح الغزالي وهو مقتضى كلام إمام الحرمين والجماهير
وأما المتكلمون في اللساني فيقع اختلافهم على قولين
أحدهما أنه يدل عليه بطريق الالتزام وهو رأي المعتزلة
والثاني أنه لا يدل عليه أصلا ولبعض المعتزلة مذهب ثالث وهو أن أمر الإيجاب يكون نهيا عن أضداده ومقبحا لها بكونها مانعة من فعل الواجب
بخلاف المندوب فإن أضداده مباحة غير منهي عنها لا نهي تحريم ولا نهي تنزيه ولم يقل أحد هنا إن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده لكون مكابرة وعنادا كما قررناه واختار الآمدي أن يقال إن جوزنا تكليف ما لا يطاق فالأمر بالفعل ليس نهيا عن الضد ولا مستلزما للنهي عنه بل يجوز أن يؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة وإن منع فالأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده
هذا خلاصة ما يجده الناظر في كتب الأصول من المنقول في هذه المسألة وهو هنا على أحسن تهذيب وأوضحه ومنهم من أجرى الخلاف في جانب النهي هل هو أمر بضد المنهي عنه وقال إمام الحرمين من قال النهي عن الشيء أمر يأخذ أضداده فقد اقتحم أمرا عظيما وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة فإنه إنما صار إلى ذلك من حيث قال لا شيء يقدر مباحا إلا وهو ضد محظور فيقع من هذه الجهة واجبا ومن قال الأمر بالشيء نهي عن الأضداد ومتضمن لذلك من حيث تفطن لقائله الكعبي فقد ناقض كلامه فإنه كما يستحيل الإقدام على المأمور به دون الإنكفاف عن أضداده فيستحيل الانكفاف عن المنهي دون الإنصاف بأحد أضداده ونختم الكلام في المسألة بفوائد
أحدها قال القاضي عبد الوهاب في الملخص بعد أن حكى عن الشيخ أبي الحسن أن الأمر بالشيء نهي عن ضده إن كان ذا ضد واحد
واضداده إن كان ذا أضداد أن الشيخ شرط في ذلك أن يكون واجبا لا ندبا قال القاضي عبد الوهاب وقد حكى عن الشيخ أنه قال في بعض كتبه إن الندب حسن وليس مأمورا به وعلى هذا القول لا يحتاج إلى اشتراط الوجوب في الأمر إذ هو حينئذ لا يكون إلا واجبا قال القاضي عبد الوهاب ولا بد أن يشترط الشيخ في ذلك أن يكون مع وجوبه مضيقا مستحق العين لأجل أن الواجب الموسع ليس ينهى عن ضده قال ولا بد أيضا من اشتراط كونه نهيا عن ضده وضد البدل الذي منه هو بدل لهما إذا كان أمرا على غير وجه التخيير انتهى
وما قاله من اشتراط كونه نهيا عن ضده وضد البدل منه لا يحتاج إليه بعد معرفة صورة المسألة فإن صورتها في الأمر الذي غير وجه التخيير كما صرح به القاضي في مختصر التقريب والإرشاد لإمام الحرمين فإنه قيد الكلام بالأمر على التنصيص لا على التخيير ثم قال وإنما قيدنا الكلام بانتفاء التخيير لأن الأمر المنطوي على التخيير قد يتعلق بالشيء وضده ويكون الواجب أحدهما لا بعينه فلا سبيل لك إلى أن تقول فيما هذا وصفه إنه نهي عن ضده إذا خير المأمور بينه وبين ضده ولقائل أن يقول محل التخيير لا وجوب فيه فأين الأمر حتى يقال ليس نهيا عن ضده ومحل الوجوب لا تخيير فيه وهو نهي عن ضده وما قاله القاضي عبد الوهاب من اشتراط التضييق لم يتضح لي وجهه فإن الموسع إن لم يصدق عليه أنه واجب فأين الأمر حتى يستثنى من قولهم الأمر بالشيء نهى عن ضده وإن صدق عليه أنه واجب بمعنى أنه لا يجوز إخلاء الوقت عنه فضده الذي يلزم من فعله تقويته منهي عنه وحاصل هذا أنه إن صدق الأمر عليه انقدح كونه نهيا عن ضده وإلا فلا وجه لا ستثنائه كما قلنا في المخير
الثانية قال النقشواني لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده للزم أن يكون
الأمر للتكرار وللفور لأن النهي كذلك وأجاب القرافي بأن القاعدة أن أحكام الحقائق التي تثبت لها حالة الاستقلال لا يلزم أن تثبت لها حالة التبعية
الثالثة سأل القرافي في مسألة مقدمة الواجب عن الفرق بينها وبين هذه المسألة فإن عدم الضد مما يتوقف عليه الواجب وأجيب بأن ما لا يتم الواجب إلا به وسيلة للواجب لازم التقدم عليه فيجب التوصل به إلى الواجب لئلا يعتقد أن حالة عدم المقدمة خال عن التكليف لزعمه بأن الأصل ممتنع الوقوع وهوغير مكلف بالمقدمة فقلنا هذا غلط بل أنت قادر على تحصيل الأصل بتقديم هذه المقدمة فعليك فعلها فكان إيجاب المقدمة تحقيقا لإيجاب الأصل مع تقدير عدم المقدمة وترك الضد أمور يتبع حصوله حصول المأمور به من غير قصد وهذا أصلح وجهين أجاب بهما في شرح المحصول
الرابعة سأل القرافي عن الفرق بين هذه المسألة وقولهم متعلق النهي فعل الضد لا نفس لا تفعل فإن قولهم نهي عن ضد معناه أنه تعلق بالضد وقولهم متعلقة ضد المنهي عنه هو الأول بعينه وسنستقصي الجواب عن هذا في كتاب الأمر والنهي إن شاء الله تعالى فإن المصنف ذكر تلك المسألة ثمة
الخامسة من فوائد الخلاف في هذه المسألة من الفروع ما إذا قال لزوجته إن خالفت نهي فأنت طالق ثم قال قومي فقعدت ففي وقع الطلاق خلاف مستند إلى هذا الأصل
المسألة السادسة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
قال السادسة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من التركذهب الأكثرون إلى أنه إذا نسخ وجوب الشيء بقي جوازه وخالف الغزالي وقال إنه إذا نسخ رجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من تحريم أو إباحة وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن وهذا الذي ذهب إليه الغزالي نقله القاضي في التقريب عن بعض الفقهاء وقال تشبث صاحبه بكلام ركيك تزدريه أعين ذوي التحقيق واحتج المصنف على اختياره بأن الجواز جزء من ماهية الوجوب إذ الوجوب مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك فاللفظ الذي دل على الوجوب يدل التضمن على الجواز والناسخ وإنما ورد على الوجوب وهو لا ينافي الجواز لارتفاع الوجوب بارتفاع المنع من الترك ضرورة أن المركب يرتفع بارتفاع أحد جزئيه ونحن نقول إن أراد القوم بالجواز الذي يبقى التخيير بين الفعل والترك كما صرح به بعضهم وهو مقتضى كلام الغزالي في الرد عليهم حيث قال حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينهما بتسوية الشرع فالحق مع الغزالي لأن التخيير بين الفعل والترك قسم للوجوب ولم يكن ثابتا به فما وجه قولهم يبقى بعده وهذا الدليل الذي ذكروه عليه لا يثبت به مدعاهم لأن التخيير بين الفعل والترك ليس في ضمن الوجوب وإنما الذي في ضمن الوجوب رفع الحرج وإن أرادوا رفع حرج الفعل فلا ينبغي أن يخالفوا في ذلك فإن الوجوب أخص منه ولما ثبت بالإيجاب الأول ثبت به الأعم
الذي هو رفع الحرج ضرورة كونه ضمنه ثم ارتفاعه لا يوجب ارتفاع الأعم والظاهر أنه لم يريدوا غير هذا القسم حيث جعلوا شبهة الخصم فيه أن الجنس يتقوم بالفصل ولا يحسن ذكر هذه الشبهة إلا إذا كان النزاع في رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد بالتخيير وحينئذ قد يضعف قول الغزالي في الرد عليهم أن هذا بمنزلة قول القائل كل واجب فهو ندب وزيادة فإذا نسخ الوجوب بقي الندب ولا قائل به لأنا نقول المدعي بقاء الجواز الذي هو قدر مشترك بين الندب والإباحة والكراهة في ضمن واحد من الأنواع الثلاثة لا بقاء نوع منها على التعيين فإنه لا بد له من دليل خاص فكيف يكون هذا بمنزلة قول القائل إذا نسخ الوجوب بقي الندب فإن قلت تحرر من هذا أن القوم يقولون ببقاء مطلق الجواز مكتسبا من دلالة الواجب عليه والغزالي ينكر كونه مكتسبا من دلالة الواجب عليه ولا تنازع في بقاء رفع الحرج فالخلاف حينئذ لفظي قلت الغزالي كما سلفت الحكاية عنه يقول إن الحال يعود إلى ما كان عليه من تحريم وإباحة فهو منازع في أصل بقاء الجواز ويظهر فائدة الخلاف فيما إذا كان الحال قبل الوجوب تحريما فعند الغزالي الفعل الآن يعود محرما كما كان وعند القوم أن مطلق الجواز الذي كان داخلا في ضمن الوجوب باق يصادق ما دل على التحريم فوضع أن الخلاف معنوي
واعلم أن الغزالي قد يقول إذا اقتضى الأمر مجموع الشيئين أعني الأعم والأخص فالذي يزيل الواحد نازل منزلة المخصص بالقياس إلى اللفظ العام ولذلك يجوز اقترانه بالأمر بأن يراد صيغة افعل ويقترن بها ما يدل على أنه لا حرج في تركه فإنا نحملها على الندب أو الإباحة ولو كان ناسخا لما جاز اقترانه به لأن من شروط الناسخ التراخي فإن قلت نحن نسلم أن هذا القيد إذا اقترن لم يكن نسخا ولكن لم قلت إنه إذا تأخر وثبت لا يكون نسخا قلت بقي النزاع في هذا ولعل الغزالي لا يسمي بالنسخ إلا ما رفع حكم الخطاب السابق بالكلية ويعود النزاع لفظيا قال قيل الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه قلنا لا وإن سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج
احتج من قال بأن الجواز لا يبقى فيما إذا قال نسخت الوجوب أوحرمة الترك بأن كل فصل فهو علة لوجود الجنس لاستحالة وجود جنس مجرد عن الفصول كالحيوانية المطلقة وإليه أشار بقوله يتقوم بالفصل أي يوجد به وإذا علم هذا فالجواز جنس للواجب والمكروه والمندوب والمباح وعلة وجوده في كل منها فصله فالعلة في وجوده في الواجب فصل الحرج على الترك فإذا زال ذلك الفصل زال الجواز ضرورة زوال المعلول بزوال علته وأجاب أولا بأنا لانسلم أن الجنس يتقول بالفصل وتقرير ذلك محال على الكتب الحكمية ولئن سلمنا أنه علة له فلا نسلم أنه يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس لجواز بقائه بفصل آخر يخلف ذلك الفصل وهو عدم الحرج على الترك فإنه إذا ارتفع قيد الوجوب بقي جنس الجواز ولا دليل على الحرج فيتقوم بفصل عدم الحرج ولا يكون جنسا مجردا
واعلم أن خلاف الأصوليين في هذه يناظر اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم وذلك فيمن صلى الظهر قبل الزوال فإنها لا تنعقد ظهرا وفي انعقادها نفلا هذا الخلاف ويضاهيه مسائل
منها إذا أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم وجد بالمبيع عيبا فرده فالأصح أن الحوالة تبطل وهل للمحتال قبضه للمالك بعموم الإذن الذي تضمنه خصوص الحوالة فيه هذا الخلاف
ومنها إذا عجل الزكاة بلفظ هذه زكاتي المعجلة فقط فهل له الرجوع إذا عرض مانع أصح الوجهين نعم
والثاني يقع نفلا وقربهما إمام الحرمين من القولين فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال هل ينعقد نفلا
ومنها الصحيح أنه لا يصح تعليق الوكالة على شرط ولو علق وتصرف الوكيل بعد حصول الشرط فأصح الوجهين الصحة لأن الإذن حاصل وإن فسد العقد وخالف الشيخ أبو محمد وقال لا اعتبار بما يتضمن العقد الفاسد من الإذن
ومنها لو قالت وكلتك بتزويجي قال الرافعي فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعتدون به إذنا لأن توكيل المرأة في النكاح باطل قال لكن الفرع غير مسطور ويجوز أن يعتد به إذنا لما ذكرناه في الوكالة
قلت ويتجه بناء فروع على هذا الأصل لم أر من بناها
منها قال الماوردي إذا فسدت الشركة بطل أصل الإذن في التصرف ولم يجز لواحد منهما التصرف في جميع المال وينقدح لك أن تحكم بجريان الخلاف في الوكالة
ومنها إذا باع بلفظ السلم فإنه ليس بسلم قطعا وفي انعقاده بيعا قولان أظهرهما لا وبناهما الأصحاب على أن الإعتبار باللفظ أو بالمعنى ويتجه بناؤهما على هذا الأصل أيضا
ومنها إذا شرطا الخيار لثالث وأبطلناه فهل يكون الخيار لهما لكونهما شرطا مطلق الخيار يتجه فيه هذا البناء
ومنها إذا أحال بالدراهم على الدنانير أو بالعكس لم يصح سواء قلنا الحوالة استيفاء أم اعتياض
قال صاحب التتمة ونعني بقولنا إنها غير صحيحة أن الحق لا يتحول بها من الدنانير إلى الدراهم وبالعكس ولكنها إذا جرت فهي حوالة على من لا دين عليه وفيها خلاف
قلت وإنما تكون حوالة على من لا دين عليه ببطلان خصوص الحوالة على الوجه الذي أورده إذا قلنا إن الخاص إذا ارتفع يبقى العام
المسألة السابعة الوجوب لا يجوز تركه
قال السابعة الواجب لا يجوز تركه قال الكعبي فعل المباح ترك الحرام وهو واجب قلنا لا بل به يحصلالقصد بهذه المسألة أن ما يجوز تركه لايكون فعله واجبا والخلاف في هذا الفصل مع فرقتين
الأولى الكعبية فنقول لاح من قول أبي القاسم الكعبي وهو البلخي وشيعته إنكار المباح وقد خالفوا في ذلك عصابة المسلمين حيث أجمعوا على انقسام الأحكام إلى الخمسة ولا بد من تخليص محل النزاع ليقع الحجاج على محز واحد
واعلم أن إنكارهم المباح يحتمل وجهين
أحدهما أنه ليس فعل من أفعال المكلفين بمباح وقد صرح بحكاية هذا عن الكعبي جماعة منهم إمام الحرمين في البرهان فإنه قال إن الكعبي أنكر المباح في الشريعة وكذلك نقل أبو الفتح بن برهان في الوجيز والآمدي وغيرهم وهذا ظاهر الفساد
والثاني وهو الذي أشعر به دليله أن كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار أنه يترك به الحرام ولا يكون الكعبي حينئذ مفاجئا بانكار المباح وقد نقل القاضي في مختصر التقريب والغزالي في المستصفى أن المباح مأمور به دون الأمر بالندب والندب دون الأمر بالإيجاب وقد صرح في مختصر التقريب بأنه لا يسمى المباح واجبا ولا الإباحة إيجابا إذا عرفت ذلك فقد استدل الكعبي على هذا بأن فعل المباح ترك الحرام لأنه ما من مباح إلا وهو ترك لمحظور وترك الحرام واجب فيلزم أن يكون فعل المباح واجبا من جهة وقوعه تركا لمحظور
وأجاب عنه المصنف بأنا لا نسلم أن فعل المباح هونفس ترك الحرام يعني أنه يلزم من فعل المباح ترك الحرام ولا يلزم من ترك الحرام فعل المباح لجواز تركه بواجب أو مندوب فلا يكون المباح ترك الحرام بل شيئا يحصل به تركه لما عرفت من أن تركه قد يحصل به وقد يحصل بغيره فلم بنحصر تركه في المباح وقد ضعف الآمدي وغيره هذا الجواب وقالوا هو صادر ممن لم يعلم غور كلامه فإنه إذا ثبت أن ترك الحرام واجب وأنه لا يتم بدون التلبس بضد من أضداده وقد تقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالتلبس بضد من أضداده واجب غايته أن الواجب من الأضداد غير معين قبل تعيين المكلف له ولكن لا خلاف في وقوعه واجبا بعد التعيين وقال لا خلاص عنه إلا بمنع وجوب المقدمة قال وغاية ما ألزم أنه لو كان الأمر على ما ذكرت لكان المندوب بل المحرم إذا ترك به محرم آخر كالزنا إذا حصل به ترك القتل أن يكون واجبا وكان يجب أن تكون الصلاة حراما على هذه القاعدة عندما إذا ترك بها واجبا آخر وله أن يجيب بأنه لا مانع من الحكم على الفعل الواحد بالوجوب والتحريم بالنظر إلى جهتين مختلفتين كما في الصلاة في الدار المغصوبة قال وبالجملة إن استعيد فهو في غاية الغوص والإشكال وعسى أن يكون عند غيري حله
قلت وهو صحيح ولكنا نقول للكعبي نحن لا ننكر أن الإباحة تقع ذرائع إلى الانكفاف عن المحظور كغيرها من الأفعال التي يلزم منها الانكفاف
عن غيرها ووقوعها كذلك لا يخرجها عن أن تكون في نفسها مباحة فترك الحرام الذي لزم عن فعل المباح ليس هو نفس فعل المباح بل أمر وراءه وإن زعم أنها ذات جهتين فلا تنازعه في ذلك ولكن ننكر عليه تخصيصه المباح بذلك وقد بينا أنه لايختص به ويعظم النكير عليه تخصيصه المباح بذلك وقد بينا أن لا يختص به ويعظم النكير عليه في إنكاره أصل المباح في الشريعة إن صح عنه وما ذكره من الدليل لا يقتضي ذلك
قال وقالت الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر لأنهم شهدوا الشهر وهو موجب وأيضا عليهم للقضاء بقدره قلنا العذر مانع والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب وإلا لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت
الفرقة الثانية كثير من الفقهاء فإنهم خالفوا في ذلك وزعموا أن الصوم واجب على الحائض والمسافر والمريض مع أنهم يجوز لهم تركه وقد احتجوا على مذهبهم بأن هؤلاء شهدوا الشهر فيجب الصوم عليهم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وبأن القضاء يجب عليهم بقدر ما فاتهم وذلك دليل على أنه بدل عنه
وأجاب بأن شهود الشهر إنما يكون موجبا للصوم عند انتفاء الأعذار والعذر هنا قائم أما في الحائض فلأن الشرع منعها من الصوم وأما في المسافر فلأنه جعل السفر مانعا من تحتم الصوم فيه وأما في المريض فلعدم القدرة إن كان عاجزا أو بمنع الشرع إن أفضى به إلى هلاك نفسه أو بمنع الشرع من الإيجاب كالمسافر إن لم يفض إلى ذلك وعن الثاني بأن القضاء إنما يتوقف على تحقيق سبب الوجوب في الوقت وسبب الوجوب وهو شهود الشهر متحقق فيما نحن فيه الوقت ولا يتوقف على وجوب الأداء وإلا لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت لعدم تحقق الوجوب عليه لإفضائه إلى تكليف الغافل وذهب
الإمام إلى أنه يجب على الحائض والمريض البتة ويجب على المسافر صوم أحد الشهرين إما الحاضر أو آخر غيره وأيهما أتى به فهو الواجب كما في الكفارات وهذا هو مذهب القاضي نص عليه في التقريب ونقل الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع هذا بعض الأشعرية فإن قلت هذا مدخل لأن المريض يجوز له الصوم كالمسافر فليسو الإمام بينهما قلت المريض إن أفضى به الصوم إلى هلاك نفسه أو عضوه فإنه يحرم عليه الصوم ويساوي الحائض والحالة هذه وإن لم يفض به إلى ذلك بل خاف منه مجرد زيادة العلة أو طول البرء فالمسألة مختلف فيها وكذا لو خاف المرض المخوف فلعل الإمام يرى في كل هذه الصور أنه لا يجوز له لا إفطار فلا معترض عليه وقد قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إن الخلاف في هذه المسألة مما يعود إلى العبارة ولا فائدة له لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف قلت وقد نقل ابن الرفعة أن بعضهم قال بظهور فائدة الخلاف إذا قلنا أنه يجب التعرض للأداء أو القضاء في النية وقد يقال بظهور فائدة الخلاف أيضا فيما إذا طافت المرأة ثم حاضت قبل ركعتي الطواف هل تقضيهما فقد حكى النووي في شرح المهذب عن ابن القاص
والجرجاني في المعاياة إن ركعتي الطواف تقضيهما الحائض لأنهما لا يتكرران قال وأنكر الشيخ أبو علي السنجي هذا وقال الوجوب لم يكن في زمان الحيض فكيف يسمى قضاء قال النووي وما قاله الشيخ أبو علي هو الصواب لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتهما إلا بالفراغ من الطواف قال فإن قدر أنها طافت ثم حاضت عقب الفراغ من الطواف صح ما ذكرناه إن سلم لهما ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصورة
الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
الفصل الأول في الحاكم
قال الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه وفيه ثلاثة فصول الأول في الحاكم وهو الشرع دون العقل لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباحهذا الباب معقود لأركان الحكم وهي ثلاثة الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به الأول في الحاكم وهو الشرع فلا تحسين ولا تقبيح بغيره وذهبت المعتزلة إلى أن العقل له صلاحية الكشف عنهما وأنه لا يفتقر معرفة أحكام الله تعالى إلى ورود الشرائع وإنما الشرائع مؤكدة لما تقضي به العقول إما بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو بالنظر كحسن الكذب النافع أو باستعانة الشرع كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح أول يوم من شوال
واعلم أن الحسن والقبح قد يراد بهما كون الشيء ملائما للطبع ومنافرا أو كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح وبهذا التفسير لا نزاع في كونهما عقليين إنما النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا ولذلك قال القاضي في مختصر التقريب إنما المقصد تحقيق ما يحسن في قضية التكليف ويقبح وتفاصيل هذه المسألة وحجج الأصحاب فيها
مبسوطة في الكتب الكلامية والمصنف أحال القول في ذلك على كتابه مصباح الأرواح
فإن قلت قد علم مذهب أهل السنة رضي الله عنهم في أن الأحكام إنما تثبت من جهة الشرع ولا شيء منها عقلي فما معنى ما يأتي في عبارة أهل السنة من الفقهاء من قولهم هذا حرام بالعقل وهذا جائز بالعقل وما شابه ذلك قلت هذا سؤال لنا غرض صحيح في الجواب عنه لوقوف جماعة من الشاكين في الفقه على أمثال هذه العبارة ووقوع الريب في قلوبهم من قائلها والكلام عليه وإن كان كالدخيل في هذا الشرح إلا أن غيرنا لا يقوم به فلنفده طالبه فنقول المراد من ذلك إما القياس وإما أن القاعدة الكلية لما ثبتت من الشرع ورأينا الفرع الجزئي من جملة أقسامها أدرك العقل دخوله في القاعدة فقيل ثبت بالعقل وهذا معناه كما نقول الوتر يصلى على الراحلة وكل ما يصلى على الراحلة فهو سنة فالوتر سنة بالعقل بمعنى أن العقل أدرك النتيجة لا أنه جعل الوتر سنة ومن هذا القبيل أن الشافعي رضي الله عنه أطلق القول في المختصر بتعصية الناجش وهو الذي يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغب فيها ليخدع الناس ويرغبهم فيها وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالحديث الوارد فيه قال الشارحون السبب فيه أن النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد معلوم من الألفاظ العامة وإن لم يعلم هذا الخبر بخصوصه والبيع على بيع الأخ إنما عرف تحريمه من الخبر الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف الخبر وذكر بعضهم أن تحريم الخداع يعرف بالعقل وإن لم يرد الشرع واعترض الرافعي على هذا بأنه ليس معتقدنا ولك أن تجمع بين
كلام الشارحين وهذا الكلام بأن الخديعة لما كانت محرمة من الألفاظ العامة أدرك العقل تحريم النجش لأن كل نجش خديعة وكل خديعة حرام ينتج النجش حرام ومراده بقوله وإن لم يرد شرع أي خبر خاص لا القول بأن العقل يحسن ويقبح كما فهمه الرافعي فإن قلت فالبيع على بيع الأخ إضرار وكما يعرف تحريم النجش من الألفاظ العامة في تحريم الخداع يعلم تحريم البيع على البيع من الألفاظ العامة في تحريم الإضرار قلت كذا اعترض به الرافعي رحمه الله لكن لقائل أن يقول لا يوجد البيع على بيع الأخ من الألفاظ العامة في الاضرار بخلاف النجش والفرق أن النجش لا يجلب للناجش مصلحة لأنه لا غرض له إلا الزيادة في ثمن السلعة ليجلب نفعا لصاحبها يلزم منه الإضرار بالمشتري وجلب منفعة لشخص بإضرار آخر حرام واضح من القواعد المقررة
وأما البيع على البيع فهو يدعو أخاه إلى فسخ البيع ليبيعه خيرا منه بأرخص ففيه جلب منفعة له من حيث ترويج سلعته وللمشتري من جهة شراء الأجود بأرخص فهاتان مصلحتان لم يعارضهما إلا مفسدة وهي غير محققة لجواز أن البائع الأول يبيع سلعته إذا فسخ البيع فيها من مشتر آخر بذلك الثمن أو أزيد فلا يلزم من تحريم جلب منفعة واحد لازمها وقوع مفسدة في صورة النجش تحريم جلب منفعة اثنين بمجرد ظن ترتب مفسدة عليها فوضح أن العقل لم يكن قبل ورود الخبر الخاص في البيع على البيع ليدرك تحريمه لما ذكرناه بخلاف النجش
واعلم أيضا أنه يأتي في عبارات بعض الأصحاب ما يؤخذ منه قاعدة التحسين والتقبيح أو يستلزم قاعدة التحسين والتقبيح أو يستلزم قاعدة التحسين
والتقبيح كقول أبي العباس بن سريح وأبي علي بن أبي هريرة والقاضي أبي حامد المروزي إن شكر المنعم واجب عقلا وقول القفال إن القياس يجب العمل به عقلا وقوله إن خبر الواحد يجب العمل به عقلا إلى غير ذلك من المسائل وسببه كما قال الأستاذ أبو إسحاق في كتابه في أصول الفقه في مسألة شكر المنعم هذه الطائفة من أصحابنا إنما ذهبت إلى هذه الآراء لأنهم كانوا يطالعون كتب المعتزلة لشغفهم بمسائل هذا العلم فربما عثروا على هذه العبارة وهي شكر المنعم على النعمة قبل ورود السمع فاسحسنوها فذهبوا إليها ولم يقفوا على القبائح والفضائح التي تحتها هذا كلام الأستاذ وكذلك ذكر القاضي أبو بكر في التخليص الذي اختصره إمام الحرمين من كتابه التقريب في مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع فإنه قال مال بعض الفقهاء إلى الحظر وبعضهم إلى الإباحة وهذا لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة مع علمنا بأنهم ما استحسنوا مسالكهم وما اتبعوا مقاصدهم انتهى وهذه فائدة عظيمة جليلة
فرعان على الحسن والقبح
قال فرعان على التنزل الأول شكر المنعم ليس بواجب عقلا إذ لا تعذيب قبل الشرع لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولأنه لو وجب لوجب إما لفائدة المشكور وهو منزه أو للشاكر في الدنيا وأنه مشقة بلا حظ أو في الآخرة ولا استقلال للعقل لها
هذان فرعان على قاعدة الحسن والقبح جرت عوائد الأصحاب بذكرهما بعد إبطال مذهب المعتزلة فيها لشدة سخافة مذهب المعتزلة بالنسبة إليهما ولهذا يقال إنهما على التنزل أي الافتراض والتكليف في النزول عن المذهب الحق الذي هو الذروة إلى مذهبهم الباطل الذي هو في الحضيض الأول شكر المنعم غير واجب عقلا خلافا للمتزلة وبعض الحنفية وأما وجوبه شرعا فمتفق عليه والمراد بوجوب الشكر عقلا أنه يجب على المكلف تجنب المستقبحات العقلية وفعل المستحسنات العقلية كذا نقله بعض أصحابنا عنهم قال صفي الدين الهندي ولا يبعد أن يراد به ما نريد به نحن في الشرع وهو أن الشكر يكون باعتقاد أن ما به من نعمة فمن الله وأنه المتفضل بذلك عليه فإن نعمة الخلق والحياة والصحة غير مستحق عليه وفاقا ويكون بالفعل وهو بامتثال أوامره واجتناب مناهيه وبالقول وهو أن يتحدث بنعمة ربه واحتج في الكتاب على ما ذهب إليه بوجهين
الأول قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
ووجه الدلاله فيه ظاهر وتقريره أنا مفرعون على القول بالحسن والقبح والشرع على القول بأن العقل يحكم كاشف وقد أخبر أن التعذيب منتف قبل البعثة فدل على أن العقل اقتضى ذلك ولو وجب شكر المنعم لحصل التعذيب بتركه ولم يتوقف على بعثه الرسل فاضبط هذا التقرير ولا تعدل به
والثاني أنه لو وجب لوجب لفائدة أن التفريع على القول بقاعدة الحسن والقبح والإيجاب على القول بها يستدعي فائدة وإن شئت قلت لو وجب لوجب إما بلا فائدة وهو عبث مستقبح عقلا ولكن يلزم على هذا أن يكون المصنف أخل بأحد الأقسام وأما لفائدة عائدة إلى المشكور وهوسبحانه وتعالى وهو محال لتنزهه عن الفوائد والأغراض أو عائدة إلى العبد الشاكر في الدنيا وهو أيضا باطل لأنه مشقة وكلفة على النفس من غير حظ ونفع أو عائدة إليه في الآخرة وهو أيضا باطل إذ لا استقلال للعقل بمعرفة الفوائد الأخروية على وجه التفصيل وهذا مسلم لكن ليس من شرط الوجوب العلم بالفوائد التفصيلية وإن أريد الإجمالية فلا نسلم أن العقل لا يستقل بمعرفتها وذلك لأن القول في هذا مبني على قاعدة الحسن والقبح وهي تقطع باتصال الثواب بفعل الواجبات العقلية والعقاب بتركها ولقائل أن يقول العقل لا يستقل بإدراك الآخرة وكيف يستقل بالحكم بوجود دار أخرى مخلوقة للجزاء والإحسان وإذ لم يستقل بإدراكها لم يحكم بما يترتب عليها
قال قيل يدفع ظن ضرر الآجل قلنا قد يتضمنه لأنه تصرف في ملك الغير وكاستهزاء لحقارة الدنيا بالنسبة إلى كبريائه ولأنه ربما لا يقع لائقا قيل ينتقض بالوجوب الشرعي قلنا إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة
اعترض على الوجه الآخر بوجهين
أحدهما أنا نقول بعود الفائدة إلى العبد الشاكر في الدنيا
قوله مشقة وكلفة بلا حظ قلنا لا نسلم أنه لا حظ لها في الشكر وذلك لأن فائدة الشكر اندفاع ظن العقاب في الآخرة على تركه لأن العقاب على ترك الشكر احتمال راجح يوجب للنفس القلق وعدم الطمأنينة بل مجرد توهم العقاب قد يحصل فيه ذلك وأجاب المصنف بأن ترك الشكر كما أنه يستدعي ما ذكرتم كذلك الإقدام عليه وذلك لأن من أقدم على الشكر فقد استعمل الأعضاء والقوى المملوكة لربه سبحانه وتعالى وتصرف فيها بغير إذنه والتصرف في ملك الغير بغير إذنه يوجب ما ذكرتم وأيضا فالشكر لأنعمه تعالى منزل منزلة المستهزئ بالمنعم لأن نعم الدنيا وإن جل خطبها فهي بالنسبة إلى كبريائه تعالى أقل من لقمة بالنسبة إلى ملك عظيم لأن نسبة ما يتناهى إلى
مثله أقل من نسبته إلى ما لا نهاية له ولا ريب في أن القائم في المحافل يشكر الملك بسبب ما أسداه إليه من لقمة خبز معدود من المستهزئين مستوجب للتأديب وأيضا فالشكر للملك العظيم إنما يكون على وجه لائق بجنابه وقد لا تهتدي العقول إلى ذلك الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى فيستحق العقاب بسببه
فإن قلت لما فسر الشكر باجتناب القبيح وإتيان الحسن عقلا اندفع ما ذكرتم للعلم بالشكر اللائق حينئذ كما هو معلوم بعد ورود الشرع قلت هب أن الأمر كما ذكرت لكن الإتيان بما ذكرت من الشكر يتوقف على استقباح العقل وتحسينه فربما يستقبح الحسن ويستحسن القبيح لأن العقول غير معصومة عن الخطأ لا يقال قد تعارضت الاحتمالات والمواظبة على الخدمة أنجى من الإعراض والإهمال لأنا نقول ذلك في مشكور يسره الشكر ويسوؤه الكفران والله تعالى مبرأ عن ذلك
الوجه الثاني أن ما ذكرتم منقوض بوجوب الشكر شرعا فلو كان ما ذكرتموه صحيحا لم يجب بعين ما قررتم بأن يقال لو وجب شكر المنعم شرعا لوجب لفائدة إلى آخر ما أوردتم وأجاب بأن الدليل المذكور لا يطرد في الوجوب الشرعي لأنه لا تعلل أحكام الله تعالى ولا أفعاله فإيجاب الشرع ليس لاستدعاء فائدة بل له بحكم المالكية أن يفعل ما يشاء وهذا جواب صحيح ماش على اللائق بأصول المتكلمين فإنهم لا يجوزون تعليل أفعال الله تعالى وهو الحق لأن من فعل فعلا لغرض كان حصوله بالنسبة إليه أولى سواء كان ذلك لغرض عائدا إليه أم إلى الغير وإذا كان كذلك يكون ناقصا في نفسه مستكملا في غيره تعالى الله عن ذلك
وأما قول المصنف في القياس تبعا للإمام دل الاستقراء على أن الله شرع الأحكام لمصالح العباد تفضلا وإحسانا فهو من كلام الفقهاء وإطلاقتهم والصواب ما ذكره هنا
فائدة قال الإمام أبو الحسن الطبري المعروف بالكيال في تعليقه في
الأصول وفي خط ابن الصلاح نقلت ذلك مسألة شكر النعم غير مسألة التحسين والتقبيح بيانه إنا نقول ليس الشكر اللفظ فما معناه قالوا المعرفة قلنا المعرفة تراد للشكر فكيف تكون نفس الشكر فلا بد أن تتقدم على الشكر فإنما شكر من عرف وإن قالوا نعني بالشكر ماتعنون أنتم قلنا الشكر عندنا امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه وإن قالوا فنحن نقول الشكر هو الإقدام على المستحسنات واجتناب المستقبحات قلنا فهذه هي مسألة التحسين والتقبيح بعينها قال لكنا أفردناها بالكلام على عادة المتقدمين
الفرع الثاني
قال الفرع الثاني الأفعال الإختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة وتوقف الشيخ والصيرفي وفسره الإمام بعدم الحكم والأولى أن يفسر بعدم العلم لأن الحكم قديم عنده ولا يتوقف تعلقه عن البعثة لتجويزه التكليف بالمحالهذا الفرع في حكم الأشياء قبل ورود الشرع وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه لا حكم فيها لأن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب على ما تقدم تفسيره فحيث لا خطاب لا حكم وأما المعتزلة فقسموا الأفعال إلى اضطرارية واختيارية
الأولى الاضطرارية وهي التي تقع بغير اختيار المكلف ولا قدرة له على تركها كالتنفس في الهواء قال الإمام وذلك مما لا بد من القطع بأنه غير ممنوع إلا إذا جوزنا تكليف ما لا يطاق
الثانية الاختيارية وهي الواقعة بإرادة المكلف مع قدرته على تركها
ومثل لها بأكل الفاكهة وبهذا يعرف أن القدر الذي لا يعيش المكلف بدونه من الأكل والشرب وغيرهما من قسم الاضطراري ومنهم من جعل ما يحصل به الاغتذاء من قسم الاختياري المتنازع فيه وتبعهم المصنف كما سنراه في كلامه إن شاء الله ولعل مرادهم الاغتذاء ما يقع فوق الضرورة إذا عرفت ذلك فقد قسموا الاختيارية إلى ما يقضي فيها العقل بحسن أو قبح واتبعوا فيها حكم العقل وتقسيمه إياها إلى الأحكام الخمسة وإلى ما لا يقضي العقل فيها بواحد منهما وهذه صورة مسألة الكتاب فقوله الاختيارية احتراز عن الاضطرارية وفاته أن يقول التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح فنقول ذهبت معتزلة البصرة وبعض الفقهاء من الشافعية والحنفية إلى أنها على الإباحة قبل ورود الشرع وذهب معتزلة بغداد وبعض الإمامية والشيخ أبو علي ابن أبي هريرة من الشافعية إلى أنها محرمة وقد سلف اعتذار القاضي والأستاذ عمن قضى في هذه المسألة بإباحة أو حظر من الفقهاء وتوقف الشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي في ذلك والخلاف في هذه المسألة جار في خطاب التكليف وخطاب الوضع على حد سواء وفسر الإمام توقف الشيخ بعدم الحكم أي بانتفاء الأحكام وهذا ما قاله النووي في أوائل باب الربا في شرح المهذب أنه الصحيح عند أصحابنا أعني انتفاء الأحكام قال صاحب الكتاب والأولى أن نفسر التوقف بعدم العلم أي بأن لها حكما قبل ورود الشرع ولكنا لا نعلم ما هو وعلل ذلك بأن الحكم قديم عند الشيخ فتفسير التوقف بعدم الحكم يلزم عنه أن يكون الحكم حادثا وهو خلاف مذهبه ثم استشعر المصنف سؤالا فأجاب عنه وتقريره أن الحكم وإن كان قديما عند الشيخ لكن تعلقه حادث لأنه متوقف على بعثة الرسل والمراد بأنه لا حكم قبل ورود الشرع أنه لا تعلق فلا يكون تفسير التوقف بعدم الحكم مخالفا لمذهب الشيخ وتقرير جوابه أن التعلق عند الشيخ لا يتوقف على البعثة لتجويزه
التكليف بالمحال فيجوز أن يتعلق الحكم بأفعال المكلفين قبل ورود الشرع مع عدم شعورهم بذلك
ولقائل أن يقول هذا حينئذ تكليف الغافل لا تكليف بالمحال والشيخ إنما يجوز الثاني ثم إن الشيخ لا يقول بوقوع التكليف بالمحال بل الحل تفسير التوقف بعدم الحكم وبه صرح القاضي في مختصر التقريب فقال صار أهل الحق إلى أنه لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع وعبروا عن نفي الأحكام بالتوقف ولم يريدوا بذلك الوقف الذي يكون حكما في بعض مسائل الشرع وإنما عنوا به انتفاء الأحكام انتهى وهو مصرح ببطلان ما ذهب إليه المصنف من التفسير وكذا قال إمام الحرمين في البرهان لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع وليس مراده إلا الوقف لعدم الحكم وقال الغزالي إن أراد أصحاب الوقف أن الحكم موقوف على ورود السمع ولا حكم في الحال فصحيح وإن أرادوا عدم العلم فهو خطأ فإن قلت الوقف هو الإمساك عن الحكم بشيء فلا يناسب تفسيره بالجزم بأن لا حكم قلت معنى الوقف يرجع إلى أن فعل المكلف قبل البعث لا يوصف بإباحة ولا حرمة لعدم التعلق به فالتوقف إنما هو في وصف الفعل لا في وجود الحكم وعدمه لكن لما كان السبب في هذا الوقف بعدم الحكم بمعنى عدم التعلق فسرنا التوقف بعدم الحكم تجوزا فإن قلت هذا لا يجامع اختياركم إن التعلق قديم قلت المراد بالتعلق هنا هو التعلق الذي يظهر أثره في المحكوم عليه وهو منتف قبل البعثة فلذلك اخترنا انتفاء الحكم قبل البعثة وفسرنا توقف الشيخ به فإن قلت هل الحكم بنفي الحكم قبل البعثة عقلي أو شرعي قلت هو عقلي لا شرعي بقي مما ننبه عليه هنا أن ما نقله المصنف عن الإمام ليس بجيد فإنه حكى في المحصول قول الوقف ثم قال هذا الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم وتارة بأنا لا ندري هل هنا حكم أم لا وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر انتهى فليس فيه اختيار ما نقله المصنف عنه
فإن قلت ما عذر المصنف في ذلك
قلت الظاهر أنه تبع صاحب الحاصل حيث قال فيه التوقف مرة يفسر بأنا لا ندري الحكم ومرة بعدم الحكم وهو الحق وظن أن صاحب الحاصل اتبع الإمام على عادته فنسب اختيار هذا القول إلى الإمام ويحتمل أن المصنف وقف للإمام على اختيار ذلك في كلام له في غير هذا الموضع أو أنه أراد بالإمام إمام الحرمين فإنه اختار ذلك في البرهان حيث قال لاحكم على العقلاء قبل ورود الشرع وهما احتمالان بعيدان
أدلة القائلين بالإباحة
قال احتج الأولون بأنه انتفاع خال عن إمام المفسدة ومضرة المالك فيباح كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره وأيضا المآكل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث واستغنائه تعالى وليس للإضرار اتفاقا فهو للنفع وهو إما التلذذ أو الاغتذاء أو الاجتناب مع الميل أو الاستدلال ولا يحصل إلا بالتناول وأجيب عن الأول بمنع الأصل وعليه الأوصاف والدوران ضعيف وعن الثاني أن أفعاله لا تعلل بالغرض وإن سلم فالحصر ممنوعاحتج الأول وهم القائلون بالإباحة بوجهين
أحدهما أنها انتفاع خال عن إمارة المفسدة فإن الكلام مفروض في فعل لا يظهر له مفسدة وخال عن مضرة المالك لأن المالك هو الله المنزه عن المضار المبرأ عن المنافع فتكون مباحه قياسا على الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بناره بغير إذنه فإنه أبيح لخلوه عن أمارات المفسدة ومضرة المالك فلما وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجودا وعدما والدوران يدل على علية المدار للدائر دل على عليتها لإباحة الأفعال وهي صورة النزاع فيلزم الإباحة فيها وتمثيل المصنف بالاقتباس فيه نظر لأن الاقتباس أخذ جزء من النار وهو لا يجوز بغير الإذن فالأولى التمثيل بالاستضاءة كما ذكرنا
وقد ذكر الرافعي جواز الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بناره والاستناد وإسناد المتاع في أثناء كلام في القسم الثاني في الجدار المشترك من كتاب الصلح وذكر القفال المسألة في الفتاوى في واقعة جرت له مع السلطان محمود وأنه يجوز السعي في أرض الغير إن لم يخش أن تتخذ بذلك طريقا وإلا
لزم منه الضرر قال وكذلك النظر في مرآة الغير والإيقاد من ناره والاستظلال بجداره والالتقاط من حبوب الزرع المتناثر ذكر القفال في الفتاوى أيضا أنه يجوز إسناد خشبة إلى جدار الغير
الوجه الثاني أن المواكيل اللذيذة إن خلقت لا لغرض كان عبثا محالا وإن خلقت لغرض فلا جائز أن يعود إلى الباري لتنزهه عن الأغراض فتعين أن يكون لغرضنا وليس هو الإضرار باتفاق العقلاء فهو حينئذ النفع وذلك النفع إما أن يكون دنيويا كالتلذذ والاغتذاء أو أخرويا يتعلق بالعمل كالاجتناب لكون تناولها مفسدة مع الميل فيستحق الثواب باجتنابها أو أخرويا يتعلق بالعلم كالاستدلال بها على وجود الصانع كمال قدرته وكل ذلك لا يحصل إلا بالتناول فواضح
وأما توقف الاجتناب عليه فلأن المكلف إنما يستحق الثواب بتجنبها إذا دعت نفسه إليها وإنما يكون ذلك بعد التناول كذا قيل والحق أن تارك المعاصي امتثالا لأمر الله تعالى مع عدم ميلانه إليها يثاب على تركها بل هو عند قوم أعلى درجة من الذي فعلها ثم انزجر عنها وأما توقف الاستدلال فلأنه إنما يكون مع معرفتها هذا تقرير الوجهين
قال في الكتاب وأجيب عن الأول بأنا لا نسلم ثبوت الحكم في المقيس عليه فإن الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره من جملة الأفعال الاختيارية الداخلة تحت صور النزاع ولئن سلمنا ثبوت الحكم في الأصل فلا نسلم أنه معلل بهذه الأوصاف واستدلالكم على ذلك بالدوران لا يفيدكم لأن الدوران وإن كان حجة فالظن الحاصل منه ضعيف لا يستدل بمثله على هذه المسألة
واعلم أن هذا لا يخالف قوله في القياس بحجة الدوران لأن القائل بحجته معترف بأنه جار في مجاري الظنون الضعيفة التي يستدل بها على الفروع الفقهية الجزئية دون المسائل الأصولية وأما من قال بأنه مفيد للقطع فلا مبالاة بمعتقده الفاسد وأجيب عن الثاني بأن الدليل المذكور مبني على تعليل أفعال الله تعالى
بالأغراض وقد بينا فيما سلف أنه لا يجوز تعليلها ولقائل أن يقول إذا كان الكلام في هذا الفرع مفرعا على القول بقاعدة التحسين والتقبيح وجب المشي فيه على قاعدة القوم وهم يعللون أفعال الله تعالى ويزعمون أنها تابعة للمصالح ثم قال المصنف ولئن سلمنا جواز تعليلها فلا نسلم انحصار الغرض فيما ذكرتم وجاز أن يكون الغرض في خلقها هو التنزه بمشاهدتها أو غير ذلك
أدلة القائلين بحرمتها
قال وقال الآخرون تصرف بغير إذن المالك فيحرم كما في الشاهد ورد بأن الشاهد يتضرر به دون الغائباحتج القائلون بأنها محرمة بأن الأفعال الاختيارية تصرف في ملك الغير بغير إذن فيحرم قياسا على التصرف في ملك الشاهد الذي هو الإنسان بغير إذنه والجامع بين ورد هذا بالفرق وهو أن حرمة التصرف في ملك الشاهد بغير إذنه إنما كانت لتضرره بذلك وهذا بخلاف الغائب وهو الله لتنزهه عن الإضرار وقد علم الواقف على هذا برد المصنف على الفريقين أنه يختار الوقف
واعلم أنه لا خلاف في الحقيقة بين الواقفية والقائلين بالإباحة كما قال إمام الحرمين قال فإنهم لم يعنوا بالإباحة ورود خبر عنها وإنما أرادوا استواء الأمر في الفعل والترك والأمر على ما ذكروه نعم لو قالوا حق على المالك أن يبيح فهذا ينعكس الآن عليهم بالتحكم في تفاصيل النفع والضرر على من لاينتفع ولا يستضر
قال تنبيه عدم الحرمة لا يوجب الإباحة لأن عدم المنع أعم من الإذن
هذا إشارة إلى جواب عن سؤال مقدر ذكره الفريقان على الواقفية بمعنى لا حكم ولك أن تقول المصنف غني عن ذكر هذا إذ هو لا يفسر التوقف بمعنى عدم الحكم بل بمعنى عدم العلم وتقرير السؤال أن الأفعال إن كانت ممنوعا منها فهي محرمة وإلا فهي مباحة
والجواب أنا لا نسلم أنها إذا لم تكن ممنوعا منها تكون مباحة لأن المباح
هو ما أعلم فاعله أو دل على أنه لا حرج في فعله ولا تركه ولا يلزم من عدم المنع الإذن لأن عدم المنع أعم من الإذن والعام لا يستلزم الخاص
الفصل الثاني في المحكوم عليه وفيه عدة مسائل
الأولى في الحكم على المعدومقال الفصل الثاني في المحكوم عليه وفيه مسائل
الأولى يجوز الحكم على المعدوم كما أنا مأمورون بحكم الرسول صلى الله عليه و سلم
قال أصحابنا المعدوم يجوز أن يحكم عليه لا بمعنى أن حال كونه معدوما يكون مأمورا فإنه معلوم الفساد بالضرورة بل بمعنى أنه يجوز أن يكون الأمر موجودا في الحال ثم إن الشخص الذي يوجد بعد ذلك يصير مأمورا بذلك وأما سائر الفرق فقد أنكروه وعظموا النكير على شيخنا أبي الحسن حتى انتهى الأمر إلى انكفاف طائفة من الأصحاب عن هذا المذهب منهم أبو العباس القلانسي من قدماء الأصحاب وقال كلام الله في الأزل لا يتصف بكونه أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا وإنما ثبتت هذه الصفات فيما لا يزال عند وجود المخاطبين كما يتصف الباري بكونه خالقا رازقا فيما لا يزال وجعل ذلك من صفات الأفعال وهذا ضعيف لأنه إثبات لكلام خارج عن كونه أمرا ونهيا ووعدا وعيدا إلى استتمام أقسام الكلام وذلك مستحيل قطعا فلئن جاز ذلك فما المانع من المصير إلى أن الصفة الأزلية ليست كلاما أزليا ثم يستجد كونها كلاما فيما لا يزال وذهب بعض الفقهاء كما حكاه القاضي في مختصر التقريب إلى أن الأمر قبل وجود المأمور أمر إنذار وإعلام وليس بأمر إيجاب وهو
ضعيف لأن ما فروا منه في الإيجاب يلزمهم في الإعلام فإنه كما يستبعد إلزام المعدوم يستبعد إعلامه واحتج أصحابنا بأن الواحد منا يصير مأمورا بأمر النبي صلى الله عليه و سلم مع أن ذلك الأمر ما كان موجودا إلا حال عدمنا
قال قيل الرسول أخبر بأن من سيولد فالله سيأمره قلنا أمر الله في الأزل معناه أن فلانا إذا وجد فهو مأمور بكذا قيل الأمر في الأزل ولا سامع ولا مأمورا عبث بخلاف أمر الرسول عليه السلام قلنا مبني على القبح العقلي ومع هذا فلاسفة في أن يكون في النفس طلب التعلم من أين سيولد
اعترض الخصوم على الدليل المتقدم بأنه لا يصح قياس أمر الله على أمر الرسول صلى الله عليه و سلم لأنه صلى الله عليه و سلم مبلغ لأمر الله تعالى فيكون مخبرا عن الله بأن فلانا إذا وجد وانخرط في سلك من يفهم الخطاب فالله يأمره بكذا وإذا كان كذلك لم يكن أمرا للمعدوم بشيء وأجاب المصنف بأنا أيضا نقول أمر الله في الأزل معناه أنه أخبر بأن من سيوجد ويستعد لتعلق الأمر به يصير مأمورا بأمري كما قلتم في أمر الرسول صلى الله عليه و سلم فإن قلت إذا كان أمر الله بمعنى الإخبار فلا يكون أمرا حقيقيا قلت كذلك ذهب إليه بعض الأشاعرة وضعفه الإمام بوجهين
أحدهما أنه إن كان مخبرا لنفسه فهو سفه أو لغيره فمحال إذ ليس ثم غيره ولهذا ذهب من صار إلى أن كلام الله في الأزل لم يكن أمرا ولا نهيا ثم صار فيما لا يزال كذلك واعترض عليه القرافي بأنا نقول إنه مخبر لنفسه والقائل يشتغل في فكره طول ليله ونهاره ولا معنى لذلك إلا الإخبارات وأجمع العقلاء مع ذلك على حسنه فلا يكون في حق الله تعالى قبيحا بل الله تعالى عالم بجميع معلوماته ويخبر عن كل معلوم بخصائص صفاته وأحواله ولا استحالة في ذلك ولم يزل الله تعالى في الأزل وأبدا ولا يسمع ذلك إلا الله تعالى بسمعه القديم وإلى هذا الإخبار أشار عليه السلام بقوله لا أحصى ثناء عليك أنت
كما أثنيت على نفسك فالله تعالى يثني على نفسه دائما أزلا وأبدا ولا معنى للثناء إلا الإخبار قال وهذا واجب حق لا ينكره إلا من لم يربض بالعلوم العقلية الكلامية
والثاني من اعتراض الإمام أنه لو كان بمعنى الإخبار لقبل الصدق والكذب ولكن يلزم ألا يجوز العفو لأن الخلف في خبر الله محال وهو ضعيف لأنا نقول الأمر عبارة عن الإخبار بنزول العقاب إذا لم يحصل عفو ذكره الأصفهاني في شرح المحصول ثم اعترض الخصم على الجواب بأن الأمر بالمعنى الذي ذكرتموه أيضا محال في حق الله تعالى دون رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه تعالى إذا أخبر في الأزل يكون قد أخبر ولا سامع ولا مأمور ومنهى وصار كمن خلا بنفسه يحدثها وذلك عبث بخلاف أمر الرسول فإن بين يديه من يسمع ويمتثل ويبلغ وأجاب بأن تقبيح هذا مبني على مسأله التحسين والتقبيح وهي منهدمة الأركان ولقائل أن يقول إن ثبت قبح هذا فهو صفة نقص ولا خلاف كما سلف في أن التحسين والتقبيح على معنى صفات الكمال والنقص عقلي وما تقدم من كلام القرافي يصلح جوابا هنا
ثم أجاب المصنف ثانيا بأن أمر الله تعالى هو المطلب القائم بذاته على رأي
أهل الحق ولا سفه في قيام طلب الفعل بذاته ممن سيوجد كما أنه لا سفه في أن يقوم بذات الأب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد ولو قدر بقاء ذلك الطلب حتى وجد الولد صار مطالبا بذلك الطلب ومأمورا فكذلك المعنى القائم بذات الله الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد قديم تعلق بعباد على تقدير وجودهم فإذا صاروا مأمورين بذلك الاقتضاء وهذا الجواب الصحيح
إلا أن قياس الغائب على الشاهد لا يصح فإنا نسلم أنه يقوم بذات الأب طلب للتعلم من ابن سيولد وإن كان الغزالي في طائفة قالوا إن ذلك ثبت للذاهبين إلى كلام النفس بل يقول إنما يقوم بذاته أنه لو وجد لطلب منه فإن قلت إنما كان ذلك لأن الشاهد غالبا لا يستيقن وجود ولد له إذ لا علم له بالغيب بخلاف من يعلم أن فلانا يوجد في الوقت الفلاني لا محالة بتقديري وإرادتي ونحن نفرض شخصا أخبره صادق بأنه يولد لك علم ولا بدع أن يقوم في نفسه والحالة هذه ما ذكرناه
قلت ولو فرضت ذلك لم نسلم صحة قيام ذلك في نفسه وكيف يطلب ولا مطلوبا منه
فإن قلت فما الفارق والحالة هذه بين الغائب والشاهد حيث أجزتم صحة قيام ذلك بذات الله بخلاف الشاهد
قلت الله تعالى ليس كلامه إلا النفسي ولا يمكن أن يكون قيامه بذاته حادثا وإلا يلزم أن يكون محلا للحوادث تعالى الله عن ذلك فلذلك لزم من هاتين المقدمتين أعني امتناع كون كلامه غير نفسي وامتناع كونه محلا للحوادث أن يكون الأمر قائما بالذات في القدم وتعلقه بالمأمور حادث على حسب استعداده وأما الشاهد الذي لا يستحيل على ذاته قيام الحوادث بها وأمره يصدق طورا باللسان وطورا بالجنان فلا ضرورة بنا إلى تقدير قيام الطلب بذاته من معدوم ومالنا لا نؤخره إلى حين يوجد ذلك المعدوم فوضح السر في كون أمر الله تعالى من الأزل وثبوت الفارق بين الغائب والشاهد وأنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر وما ذكره الخصوم من الحسن والقبح والهذيان
والسفه والانتظام والاتساق في أمر ولا مأمور وغيرها كلها من نعوت المحثات والقديم يتقدس عنه ويحقق هذا أن من أحب أن يحيط علما بقطر البحار وأوراق الأشجار عد سفيها واستقبح منه ما أتى به بخلاف الرب سبحانه وتعالى فالمعدوم الذي وجد أنه متوقف على أمره وقد قدر وجوده في وقت معلوم لا يتخلف عنه على صفة معلومة لا انفكاك لها دون أمره نازل عنده منزلة الموجود فهو يأمره وينهاه ولا قبح هذا في جانب الباري سبحانه وتعالى وهذا واضح لمن تدبره ومن أراد الزيادة فالكتب الكلامية التي وضعها أصحابنا بين أظهرنا
وإمام الحرمين قال إن هذا الموضع مما يستخير الله فيه ووعد بإملاء مجموع عليه وقال قول القائل إنه مأمور على تقدير الوجود تلبس فإنه إذا وجد لم يبق معدوما ولا شك أن الوجود شرط في كون المأمور مأمورا وإذ لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمور وهذا معضل إذن فإن الأمر من الصفات المتعلقة وفرض متعلق ولا متعلق له محال انتهى وفيما أوردناه كفاية
فائدة قال إمام الحرمين في التخليص المختصر من التقريب والإرشاد ذهب بعض من لا تحقيق له إلى أن الأمر إنما يتعلق بالمعدوم بشرط أن يتعلق بموجود واحد فصاعد ثم يتبعه المعدومون على شرط الوجود وسقوط هذا واضح
تنبيه قد يسأل عن الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع فإن الأزل قبل ورود الرسل بالضرورة وقد نفينا الأحكام قبل ورودهم ثم وأثبتناها هنا في الأزل والجواب ما تقدم في خلال الكلام من أن معنى قولنا لاحكم قبل ورود الشرع أن الخطاب إنما يتعلق بما بعد البعثة لا بما قبلها فالمنفي هناك تعلق الأحكام لا ذواتها فلا تناقض بين الكلامين
المسألة الثانية في تكليف الغافل
قال الثانية لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال فإن الإتيان بالفعل امتثالا يعتمد العلم ولا يكفي مجرد الفعل لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات ونوقض بوجوب المعرفة وأجيب بأنه مستثنىاتفق الكل حتى القائلون بجواز التكليف بما لا يطاق على أنه يشترط في المأمور أن بكون عاقلا بفهم الخطاب أو يتمكن من فهمه لأن الأمر بالشيء يتضمن إعلام المأمور بأن الآمر طالب للمأمور به منه سواء أمكن حصوله منه أو لم يمكن كما في التكليف بما لا يطاق وإعلام من لا عقل له ولا فهم متناقض إذ يصير التقدير يا من لا فهم له افهم ويا من لا عقل له اعقل المأمور به فعلى هذا لا يجوز أمر الجماد والبهيمة لعدم العقل والفهم وعدم استعدادهما ولا أمر المجنون والصبي الذي لايميز لعدم العقل والفهم التامين وإن كانا مستعدين لهما وقد نسب المصنف امتناع تكليف الغافل إلى من يحيل تكليف المحال وهو يفهم أن الذي لايحيله لا يمنعه وليس الأمر كذلك بل المختار منعه وإن فرعنا على صحة التكليف بالمحال
وعلى المصنف في قوله تكليف المحال معترض آخر وهو أن تكليف المحال هو ما رجع إلى المأمور وهو تكليف الغافل فكان الأولى أن يقول التكليف بالمحال
واستدل المصنف على المختار بأن مقتضى التكليف الإتيان بالمأمور به على وجه الإمتثال للآمر وذلك لا يتصور إلا إذا علم المكلف أن المكلف أمره به والغافل لا يعلم ذلك فلا يمكنه الإتيان بالمأمور به على جهة الامتثال
قوله ولا يكفي مجرد الفعل هذا جواب على سؤال مقدر تقديره أنا لا نسلم توقف الإتيان بالمأمور به على العلم لجواز أن يصدر عنه ما كلف من غير علم وتوجيه الجواب أن مجرد الإتيان بالمأمور به لا يكفي في حصول الامتثال بل لابد معه من النية لما ثبت من قوله صلى الله عليه و سلم إنما الإعمال بالنيات وقد نقض الخصم هذا الدليل بوجود معرفة الله تعالى فإنها واجبة ولا يمكن أن يكون وجوبه بعد حصولها للزوم تحصيل الحاصل وإذا كان قبل حصولها استحال معرفة هذا الأمر لأن معرفة أوامر الله بدون معرفة الله محال فقد كلف بما هو غافل عنه وأجاب المصنف بأنه مستثنى من القاعدة لقيام دليل عليه يخصه وقد ضعف هذا الجواب بأن النقض ولو بصورة قادح في الدليل وقيل الحق في الجواب أن يقال نختار أن التكليف بها يرد حال حصول العلم ولا يلزم تحصيل الحاصل لجواز أن يكون المأمور به معلوما بوجه ما ويكون التكليف واردا بتحصيل المعرفة من غير ذلك الوجه وقد نجز شرح ما في الكتاب
والذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه أن السكران مخاطب مكلف ولكن الأصوليين على طبقاتهم منهم القاضي في مختصر التقريب صرحوا بخروج السكران الخارج عن حد التمييز عن قضية التكليف والتسوية بينه وبين سائر من لا يفهم قال الغزالي بل السكران أسوأ حالا من النائم الذي يمكن تنبيهه فإما أن يكون ما قاله الشافعي قولا ثالثا مفصلا بين السكران وغيره للتغليظ عليه أو يحمل كلامه على السكران الذي لا ينسل عن رتبة التمييز دون الطافح المغشي عليه
ولا ينبغي أن يظن ظان من ذلك أن الشافعي يجوز تكليف الغافل مطلقا فقدره رضى الله عنه يجل عن ذلك وأظهر الرأيين عندنا أن الشافعي فصل بين السكران وغيره ثم إنا نقول لعل ذلك هو الحق دالين عليه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فإن قلت لعل المراد بالسكران في الآية النشوان الذي لا ينسل عن رتبة التمييز قلت هذا التأويل ينافي سياق الآية فإن الرب تعالى قال حتى تعلموا ما تقولون وليس عندي على من قال إن السكران مكلف إلا إشكال دقيق لولاه لجزمت القول بأنه مكلف وهو أنه يلزم من قال إنه مكلف أن يأمره بالوضوء ويطالبه بالصلاة ويرد عليه إذن قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فإن تحريم الصلاة عليه لا يجامع مطالبته بها فالآية تصلح معتصما للفريقين فمن يكلفه يقول الله خاطبه ومن يمنع يقول قد أمره بألا يقرب الصلاة فإن قلت كيف لا تكلفون النائم وهو يضمن ما يتلفه في نومه ويقضي الصلوات التي تمر عليه مواقيتها إلى غير ذلك من الأحكام
قلت الذي قلناه إنه لا يخاطب في حال نومه ولكن يتوجه عليه الخطاب بعد ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم من ترك صلاة أو نسيها فليصلها إذ ذكرها
فإن قلت إنما يخاطب في اليقظة بسبب ما تقدم في النوم
قلت مقصدنا نفي الخطاب في حال النوم فأما ثبوت أسباب يستند إليها تثبت الأحكام في اليقظة فمما لا ننكره ويوضح هذا أن الصبي الذي لا يميز لو أتلف شيئا لطالبناه ببدله فوجوب الزكوات والغرم والنفقات ليس من التكليف بل الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمة الصبيان بمعنى مخاطبة الولي في الحال بالأداء ومخاطبة الصبي بعد البلوغ وذلك غير محال وليس كقولك لمن لا يفهم افهم فإن أهلية ثبوت الأحكام في الذمة تستفاد من الإنسانية التي لها يستعد بقبول قوة العقل الذي به قوة فهم التكليف في ثاني الحال حتى أن البهيمة لما لم يكن لها قوة فهم الخطاب بالفعل ولا
بالقوة لم تتهيأ لإضافة الحكم إلى ذمتها بخلاف النطفة التي في الرحم إذا ثبت لها الملك بالإرث والوصية والحياة غير موجودة بالفعل ولكن بالقوة وكذا الصبي مصيره إلى العقل فصح إضافة الحكم إلى ذمته ومطالبته في ثاني الحال ولم يصلح للتكليف في الحال فإن قلت لو انتفخ ميت وتكسر بسبب انتفاخه قارورة فينبغي إيجاب ضمانها كالطفل يسقط على قارورة قلت يحتمل أن يقال بذلك وأن يطالب به الورثة كما يجب الضمان على العاقلة والفعل لم يصدر منهم ولكن قال الأصحاب لا يجب وفرقوا بينه وبين الطفل بأن للطفل فعلا بخلاف الميت وإيجاب الضمان على من لا فعل له غير معقول وهو متجه فإن قلت فالصبي المميز يفهم الخطاب فلم منعت تكليفه
قلت العقل لا يمنع ولكن الشرع رفع ذلك عنه بقوله صلى الله عليه و سلم رفع القلم عن ثلاث الحديث
وقد قال البيهقي إن الأحكام إنما نيطت بخمس عشرة سنة من عام الخندق وأنها كانت قبل ذلك تتعلق بالتمييز وبهذا يجاب عن سؤال من يقول الرفع يقتضي تقدم وضع ولم يتقدم على الصبي وضع فإن قلت ما الحكمة في تقدير الرفع بالبلوغ وهو إذا قارب البلوغ عقل قلت قال القاضي أبو بكر إن عدم بلوغه دليل على قلة عقله وهو تصريح منه بأن العقل يزيد ويكمل بلحظة وليس يتجه ذلك كما قاله الغزالي لأن انفصال النطفة لا يزيد عقلا لكن حط الخطاب عنه تخفيفا وزيادة العقل ونقصانه إلى حد يناط به التكليف أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه بغتة لكونه يزيد على التدريج وقد علم من عوائد الشرع أنه يعلق الحكم على مظانها المنضبطة لا على أنفسها والبلوغ مظنة كمال العقل فعقل الشارع الأمر عليه وإن جاز وجود الحكمة قبله
بلحظة أو بعده بلحظة وفي الشريعة صور كثيرة تضاهي ذلك بل ربما شذت الصورة عن الحكمة بحيث بقي الوصف فيها كضرب من التعبد وفي ذلك فروع
منها لو كمل وضوءه إلا إحدى الرجلين ثم غسلها وأدخلها الخف فإنه ينزع الأولى ثم يلبسها ليكون قد أدخلهما على طهارة كاملة
ومنها لو اصطاد صيدا وهو محرم ولا امتناع لذلك الصيد فإنه يرسله ويأخذه إذا شاء
ومنها إذا تيقن عدم الماء حواليه فإنه على وجه يلزمه الطلب وقد عددنا في الأشباه والنظائر كمله الله من ذلك كثيرا
فإن قلت كيف أمرت الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين وضربته عليها وهو ابن عشر
قلت قد علمت أن العقل بعد بلوغه سن التمييز لا يمنع من ذلك ومن محاسن الشريعة النظر في مصلحته وتمرينه على مايخاطب به حتما فيما يؤل وليس المقصود من هذا الخطاب غير ذلك ولذلك لا نقول إنها واجبة عليه بل على الولي أن يأمره بها ولا تبعة على الصبي في آخرته بتركها والله أعلم
فإن قلت كيف منعتم تكليف الغافل الداخل في قالب الموجودات وجوزتم تكليف المعدوم
قلت تكليف المعدوم بمعنى تعلق الخطاب به في الأزل على تقدير وجوده والمنع من تكليف الغافل إنما هو في زمن غفلته
فإن قلت الدهري مكلف بالإيمان وهو لا يعرف المكلف فكيف يفهم التكليف
قلت المعتبر التمكن من الفهم وهو متمكن بواسطة النظر
صلى الله عليه و سلم
المسألة الثالثة الإكراه الملجئ يمنع التكليف
قال الثالثة الإكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرةالإكراه إن انتهى إلى حد الإلجاء بحيث صارت نسبة فاعله إلى الفعل المكره عليه كنسبة المرتعش إلى حركته منع التكليف في المكره عليه أو ضده والقول في جوازه مبني على التكليف بما لا يطاق واستدل المصنف على امتناعه بزوال القدرة فإن الفعل يصير واجب الوقوع ويصير عدمه ممتنعا والتكليف بالواجب والممتنع تكليف بما لا يطاق وقال القاضي في مختصر التقريب إن هذا القسم لا يسمى عند المحققين إكراها لأن الإكراه لا يتحقق إلا مع تصور اقتدار فلا يوصف ذو الرعشة الضرويرية بالإكراه وانما المكره من يخوف ويضطر إلى أن يحرك يده على اقتدار واختيار وقد ذهب أصحابنا إلى أن ذلك لا يمنع التكليف صرح به طوائف منهم القاضي وإمام الحرمين وأبو إسحق الشيرازي والغزالي وجماعة ومال إليه الإمام وذهبت المعتزلة إلى أنه يمنع التكليف وهذا ما أفهمه كلام المصنف كذا نقله جماعة وحكاية إمام الحرمين عنهم أن المكره على العبادة لا يجوز أن يكون مكلفا بها قال وبنوا ذلك على أصولهم في وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء لا يثاب عليه قال وقد ألزمهم القاضي المكره على القتل فإنه منهي عنه وآثم به لو أقدم عليه وهذه هفوة عظيمة فإنهم لا يمنعون النهي عن الشيء مع الحمل عليه فإن ذلك أشد في المحنة واقتضاء الثواب وإنما الذي منعوه الإضرار إلى فعل مع الأمر به انتهى وقد تابع القاضي جماعة من الأصحاب على إلزام المعتزلة بذلك وهو صحيح وما ذكره إمام الحرمين حق من هذا الوجه ولكن الملزمون لم يوردوه
على هذا المأخذ بل هو من جهة أنهم منعوا أن المكره قادر على عين الفعل المكره عليه فبين الملزمون أنه قادر لأن المعتزلة كلفوه بالضد وعندهم أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة على الفعل والقدرة عندهم على الشيء قدرة على ضده فإذا قدر على ترك القتل قدر على القتل
قال الغزالي وهذا ظاهر ولكن فيه غور وهو أن الامتثال إنما يكون طاعة إذا كان الانبعاث له بباعث الأمر والتكليف دون باعث الإكراه فالآتي بالفعل مع الإكراه إن أتى به لداعي الإكراه فلا يكون مجيبا داعي الشرع فصحيح قال بعض المتأخرين وهذا الذي ذكره إنما هو في العبادات المشروط فيها النية كرد المغصوب والودائع وتسليم المبيع وحبس المعتدة فالمقصود فيه واقع قصد أو لم يقصد فيخرج من عهده التكليف به مع الإكراه هذا كلام الأصوليين وأما الفقهاء فقالوا لا يباح بالإكراه الزنا والقتل ويباح شرب الخمر والإفطار إتلاف مال الغير والخروج من الصلاة والتلفظ بكلمة الردة وقد يجب بعض ذلك فإن قلت قد قال الفقهاء إن الإكراه يسقط أثر التصرف قلت لا يلزم من كونه مسقطا أثر التصرف ألا يجامع التكليف والضابط في خطاب المكره وتصرفاته والجمع بين كلام الأصوليين والفقهاء فيه يستدعي مزيد بسط لعلنا نستقصي القول فيه في كتابنا الأشباه والنظائر على أن الفقهاء قد استثنوا مسائل من هذه القاعدة منها الإكراه على القتل على أصح القولين ومنها الإكراه على الكلام في الصلاة على الأصح ومنها الرضاع
ومنها على الحدث وقد حكى الرافعي عن الحناطي وجهين في انتقاض الوضوء بمس الذكر ناسيا فلا يبعد أن يقال بجريانهما في حالة الإكراه
ومنها الإكراه على الزنا إن قلنا يتصور الإكراه عليه
ومنها قال في الاستقصاء نقلا عن الإيضاح إذا تبايعا في عقد الصرف وتفارقا قبل القبض يبطل سواء كان في حالة الاختيار أم الإكراه وقد يعترض على هذا بأن الإكراه لا يبطل خيار المجلس في البيع على الصحيح ويجاب بضيق باب الربا والمسألة في شرح المنهاج لوالدي بطلت مبسوطة
ومنها إذا أكره ففعل أفعالا كبيرة في الصلاة بطلت بلا خلاف
ومنها لو أكره على التحول عن القبلة أو على ترك القيام في الفريضة مع القدرة فصلى قاعدا لزمه الإعادة لأنه عذر وهذه كالتي قبلها
ومنها إذا أكره حتى أكل بنفسه وهو صائم أو أكرهت المرأة حتى مكنت من نفسها ففي الفطر قولان
ومنها إذا حلف بالله مكرها انعقدت يمينه على وجه حكاه ابن الرفعة
المسألة الرابعة في وقت توجه الخطاب إلى المكلف
قال الرابعة التكليف يتوجه حال المباشرة وقالت المعتزلة بل قبلهاالمسألة من مشكلات المواضع وفيها اضطراب في المنقول وغور في المعقول ونحن نذكر مقالات الناس والتنبيه على جهة الاختلاف ثم نعمد إلى الرأي الأسد فنناضل عنه فنقول قال القاضي في مختصر التقريب باختصار إمام الحرمين الفعل مأمور به في حال حدوثه ثم قال المحققون من أصحابنا الأمر قبل حدوث الفعل المأمور به أمر إيجاب وإلزام ولكنه يتضمن الاقتضاء والترغيب والدلالة على امتثال المأمور به وإذا تحقق الامتثال فالأمر يتعلق به ولكن لايقتضي ترغيبا مع تحقيق المقصود ولا يقتضي دلالة بل يقتضي كونه طاعة الأمر المتعلق وذهب بعض من ينتمي إلى أهل الحق إلى أن الأمر إنما يقتض الإيجاب على التحقيق إذا قارن حدوث الفعل وإذا تقدم عليه فهو أمر إنذار وإعلام بحقيقة الوجوب عند الوقوع وهذا باطل والذي نختاره تحقق الوجوب قبل الحدوث وفي حال الحدوث وإنما يفترق الحالتان فيما قدمناه من الترغيب والاقتضاء والدلالة فإن ذلك يتحقق قبل الفعل ولا يتحقق معه وزعمت القدرية بأسرها أن الفعل في حال حدوثه يستحيل أن يكون مأمورا به ولا يتعلق به الأمر إلا قبل وجوده ثم طردوا مذهبهم في جملة الأحكام الشرعية فلم يصفوا كائنا بحظر ولا وجوب ولا ندب وإنما أثبتوا هذه الأحكام قبل تحقق الحدوث ثم افترقوا فيما بين أظهرهم فقال بعضهم
لا يصح تقدم الأمر على المأمور به بأكثر من وقت واحد وصار الأكثرون منهم إلى جواز تقدمه عليه بأوقات ثم الذين صاروا إلى هذا المذهب اختلفوا في
أنه هل يشترط بقاء المكلف في الأوقات المتقدمة على حدوث المأمور به على أوصاف التكليف فمنهم من شرط كونه مستجمعا لشرائط التكليف في كل الأوقات المتقدمة
وزعم بعضهم أنا لا نشترط ذلك وإنما نشترط اجتماع الأوصاف عند حدوث الفعل ويشترط في الأوقات المتقدمة عليه كون المخاطب ممن يفهم الخطاب ثم افترقوا بعد ذلك في أصل آخر وذلك أنهم قالوا هل يجوز أن يتقدم الأمر على المأمور به بأوقات من غير أن يكون فيه لطف ومصلحة زائدة على التبليغ من المبلغ والقبول من المخاطب
فمنهم من شرط أن يكون في ذلك لطف يعلمه الله ومنهم من لم يشترط ذلك انتهى وهو أثبت منقول في المسألة وصريح نقل إمام الحرمين في البرهان أن مذهب أصحاب الشيخ أن الفعل في حال حدوثه مأمور به ثم ذكر في تعليله ما يدل على أنه ليس بمأمور به قبل حدوثه وهذا هو الذي يقتضيه أصلهم وهو أن الاستطاعة عندهم مع الفعل لا قبله
فإن قلت أصلهم الآخر وهو تحويز التكليف بما لا يطاق يقتضي جواز الأمر بالفعل حقيقة قبل الاستطاعة فعلى هذا يكون المأمور مأمورا قبل التلبس بالفعل
قلت لعلهم فرعوا هذا على استحالته أو أنهم وإن جوزوه فلم يقولوا بوقوعه ويكون كلامهم هنا بناء على عدم الوقوع ثم اختار إمام الحرمين مذهب المعتزلة من الأمر بالحادث قبل الحدوث وعدم الأمر به مع الحدوث وقال إما أن يتجه القول في تعلق الأمر به طلبا واقتضاء مع حصوله مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل وأما الغزالي فإنه قال بوجود الأمر قبل الفعل وسلم مقارنة القدرة للفعل ومن هنا خالف قول إمامه فإن إمامه رأى أن القدرة هي التمكن وحالة الوجود تنافي التمكن من الفعل والترك فيتعين الوقوع كذا قال القرافي وهذه عبارة الغزالي لا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه وهل يكون الحادث في أول حال حدوثه مأمورا كما كان قبل الحدوث أو يخرج عن كونه مأمورا كما في
الحالة الثانية في الوجود اختلفوا فيه وفي بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره
وأما الإمام فقال ذهب بعض أصحابنا إلى أن المأمور إنما يصير مأمورا حالة زمان الفعل وأما قبل ذلك فلا يكون أمرا بل هو إعلام له بأنه في الزمان الثاني سيصير مأمورا
وقالت المعتزلة إنما يكون مأمورا بالفعل قبل وقوعه ثم استدل على أنه على أنه لا يمتنع كونه مأمورا حال حدوث الفعل وإذا تؤمل دليله أرشد إلى أنه اختار ما حكاه عن بعض الأصحاب من أن التكليف يتوجه حال المباشرة ولا يتوجه قبلها وهذا هو المذهب الذي حكاه القاضي عن بعض ما ينتمي إلى أهل الحق وقال إمام الحرمين لايرتضيه لنفسه عاقل ولم يتعرض الإمام إلى حكاية القول الذاهب إلى أنه مأمور قبل الحدوث ومع الحدوث وهو الذي ذهب إليه المحققون من أصحابنا كما قاله القاضي بل حاصل ما فعل أنه اختار أحد مذهبي الأصحاب واقتصر مع حكايته على حكاية مذهب المعتزلة
وقال الآمدي اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا انتهى وهذا الذي ادعى الاتفاق على خلافه إلا عن شذوذ هو أحد شقي ما اختاره الإمام ونصبه محل النزاع مع المعتزلة قال وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل واختلفوا في جواز تعلقه في أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة انتهى
وهو ما أشعر به كلام الغزالي المتقدم وهو نقل متقن محرر واتبعه عليه ابن الحاجب إلا أنه نسب القول بانقطاع التكليف حال حدوث الفعل إلى الشيخ وليس بجيد فليس للشيخ في المسألة صريح الكلام وإن كان ذلك يتلقى من قضايا مذهبه
وقال ابن برهان في أصوله الحادث في حال حدوثه مأمور به خلافا للمعتزلة انتهى ولم يتعرض له قبل الحدوث وأما صاحب الكتاب فمن شعار الإمام نبغ وقد أوردنا من النقول في المسألة ما فيه كفاية للمتبصر
أدلة القائلين بتوجه الخطاب عند المباشرة
قال لنا أن القدرة حينئذ قبل التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال قلنا الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال في الحال وإن كان غيره فيعود الكلام إليه ويتسلسل قالوا عند المباشرة واجب الصدور قلنا حال القدرة والداعية كذلكقد علمت اتباعه للإمام في اختيار أن التكليف إنما يتوجه حال المباشرة ولا يتوجه قبلها واستدل عليه بأن التكليف مشروط بحصول قدرة المكلف وحينئذ فيكون التكليف متوجها حال المباشرة ولا يكون متوجها قبلها أما تحقق القدرة حال المباشرة فلأن المراد من القدرة التمكن من الفعل والتمكن حاصل حينئذ وأما انتفاؤها قبل المباشرة فلأن الفعل قبل المباشرة ممتنع الوقوع إذ لو كان ممكن الوقوع لأمكن أن يفرض وقوعه ويكون ما فرضته أنه قبل المباشرة هو حال المباشرة وهذا خلف فوضح أن الفعل قبل المباشرة ممتنع الوقوع والممتنع لا قدرة عليه
قوله قبل التكليف أجاب الخصم عن القول بأنه إذا كان ممتنعا قبل المباشرة فلا يكلف به بأن التكليف الذي ادعينا أنه ثابت قبل المباشرة ليس هو التكليف بنفس الفعل حتى يلزم ما ذكرتم بل التكليف في الحال يعني قبل المباشرة تكليف بالإيقاع في ثاني الحال يعني حال المباشرة
واعترض المصنف على هذا الجواب بأن الإيقاع المكلف به إذا كان نفس الفعل فالتكليف به في الحال أي حال قبل الفعل محال وذلك لأنه يلزم من
امتناع التكليف بالفعل قبل مباشرته امتناع التكليف بالإيقاع إذ الفرض أن الإيقاع هو نفس الفعل وإن كان الإيقاع غير الفعل فيعود الكلام إليه أي إلى هذا الإيقاع الذي كلف به ويقال هذا الإيقاع الذي وقع التكليف به إن وقع التكليف به حال وقوع الإيقاع لزم المدعي وهو توجه التكليف حال المباشرة وإن وقع التكليف به قبله لزم أن يكون مكلفا بما لا قدرة له عليه لأنا قررنا أن القدرة مع الفعل
فإن قلت التكليف قبل الإيقاع بإيقاع الإيقاع في ثاني الحال
قلت يعود الكلام إليه أيضا ويقال إيقاع الإيقاع الذي كلف به إما أن يكون نفس الفعل أو غيره ويتسلسل فتعين أن يكون توجه التكليف حال المباشرة لا قبلها
قوله إشارة إلى حجة ذكرها المعتزلة وهي أن الفعل حال المباشرة واجب الصدور عن المكلف لامتناع الترك منه حينئذ وكل ما كان واجب الوقوع فليس بمقدور وما ليس بمقدور لا يتوجه التكليف نحوه فلا يتوجه التكليف نحو الفعل حال المباشرة وأجاب بأنه لما كانت القدرة هي التمكن من الفعل والداعية هي ميل الإنسان إلى الفعل أو الترك إذا علم أو ظن أن له في الفعل مصلحة أو مفسدة وإذا اجتمعت القدرة والداعية سميت علة تامة وإذا وجدت فقيل يجب وقوع الفعل وقيل لا يجب بل يكون الفعل أولى وإذا عرفت هذا فنقول الفعل يترتب وجوده على وجود القدرة مع الداعية فيكون مأمورا حال القدرة والداعية عند الخصم لكونه من جملة الأزمان التي قبل الفعل مع أن الفعل واجب الصدور في تلك الحالة فانتفى ما ذكرتموه ويمكن أن يقرر على وجه آخر فيقال القدرة مع الداعي مؤثرة في وجود الفعل ولا امتناع في كون المؤثر مقارنا للأثر فتكون القدرة مقارنة للفعل مع كونه واجب الوقوع فبطل دعواكم أن ما كان واجب الصدور لا يكون مقدورا والتقرير الأول أقرب إلى كلام المصنف وهو يتمشى على تقدير التزام الخصم أن العلة مع المعلول والثاني يتمشى على تقدير قوله العلة قبل المعلول وتوجيه كلام المصنف على
التقرير الثاني أن يقال فإما يكون التكليف حال القدرة والداعية معه ويلزم من مجموعهما وجوب الوقوع وقد اعترض العبري بأنه إذا كان الفعل قبل المباشرة غير مقدور عليه وعند المباشرة واجب الوقوع فيلزم التكليف بالممتنع أو الواجب وهو محال هذا شيء ما في الكتاب على الاختصار والمسألة دخيلة في هذا العلم والكلام فيها مما لا يكثر جدواه والذي نقوله هو أن الحق في أحد جهتين مرجعهما
أحداهما القول بأن التكليف متوجه قبل المباشرة وحال المباشرة أيضا وهو المنقول عن المحققين
والثانية أن التكليف لا يتوجه إلا حال المباشرة وهو مختار الإمام وصاحب الكتاب وهو عندنا منقدح لا يمنعنا عن الجزم به إلا ما سنذكره بعد سؤال وجواب نوردهما إن شاء الله تعالى
فإن قلت هذا يؤدي إلى أن المكلف لا يعصى بترك مأمور به لأنه إن أتى به كان ممتثلا وإن لم يأت كان مغدورا لعدم التكليف
قلت هذا من الأسئلة التي قامت بها الشناعة على القائل بهذه المقالة وجوابه عندنا دقيق فنقول إذا كان التكليف متوجها حال المباشرة فهو في حال ترك المأمور به مباشر للترك والترك فعل وهو حرام فقد باشر الترك فتوجه عليه التكليف بالحرمة حال مباشرة الترك والعقاب ليس إلا على الترك وهذا في غاية الحسن وقد أشار إليه إمام الحرمين في مسألة تكليف ما لا يطاق وهو أجل ما يستفاد من شرحنا في هذه المسألة وليس عندي فيه إلا أنه يلزم منه أن يقال تارك الصلاة مثلا غير مكلف بالصلاة بترك ترك الصلاة الذي يلزم منه الصلاة وقد ادعى إمام الحرمين اتفاق أهل الإسلام على أن القاعد في حال قعوده مأمور بالقيام فإن صح الإجماع هكذا فهل يصد عن القول بأن التكليف لا يتوجه إلا حال المباشرة
وإن أمكن رده إلى ترك الترك كما قررنا فهذا المذهب منقدح
الفصل الثالث في المحكوم به وفيه عدة مسائل
الأولى في جواز التلكيف بالمحالقال الفصل الثالث في المحكوم به وفيه مسائل
الأولى التكليف بالمحال جائز لأن حكمه لا يستدعي غرضا قيل لا يتصور وجوده فلا يطلب قلنا إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته
ما لا يقدر العبد عليه قد يكون معجوزا عنه متعذرا عادة لا عقلا كالطيران في الهواء وقد يكون متعذرا عقلا ممكنا عادة كمن علم الله تعالى أنه لا يؤمن فإن إيمانه مستحيل والحالة هذه عقلا لتعلق علم الله به وإذا سئل ذوو العوائد عنه حكموا بأن الإيمان في إمكانه وهكذا كل طاعة قدر في الأزل عدمها وقد يكون متعذرا عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض
إذا عرفت هذا فمحمل النزاع في التكليف بالمستحيل إنما هو المتعذر عادة سواء كان معه التعذر العقلي أم لا أما المتعذر عقلا فقط لتعلق علم الله به فأطبق العقلاء عليه وقد كلف الله الثقلين أجمعين بالإيمان مع قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فنقول ذهب جماهير الأصحاب إلى أنه يجوز التكليف بالمحال وذهبت المعتزلة إلى امتناع التكليف بالمحال مطلقا وإليه ذهب بعض أصحابنا كالشيخ أبي حامد وإمام الحرمين والغزالي واختاره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد كما صرح به في شرح العنوان وذهب قوم
إلى أنه إن كان ممتنعا لذاته لم يجز وإلا جاز واختاره الآمدي وادعى أن الغزالي مال إليه وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أنه لا يجوز أن يرد التكليف بالمحال فإن ورد لا نسميه تكليفا بل يكون علامة نصبها الله على عذاب من كلف بذلك واستدل في الكتاب على الجواز مطلقا بأن امتناع التكليف عند القائل به إنما هو لكونه عبثا وذلك مبني على تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض وهو باطل وهذا يصلح ردا على من بنى الامتناع على ذلك وهم المعتزلة وأما من وافقهم مع أصحابنا فلهم مأخذ آخر
واحتج المعتزلة ومن وافقهم بأن المحال لا يتصور لأن كل ما يتصور بالعقل فهو معلوم إذ التصور من جملة أقسام العلم وكل معلوم متميز وكل متميز ثابت لأن التميز صفة وجودية ولا بد لها من موصوف موجود ضرورة عدم قيام الموجود بالمعدوم فلو كان متصورا لكان ثابتا ولكنه غير ثابت فلا يكون متصورا وإذا كان غير متصور فلا يكلف به لأنه والحالة هذه مجهول
قال الغزالي والمطلوب ينبغي أن يكون مفهوما للمكلف بالاتفاق وأجاب المصنف بأنه إن كان غير متصور كما ذكرتم فيمتنع منكم الحكم عليه لأن الحكم على الشيء فرع تصوره فلم حكمتم عليه بالاستحالة
ولقائل أن يقول الحكم بالاستحالة إنما يتوقف على تصوره في الذهن لا على تصور وجوده في الخارج ولا يمتنع تصوره في الذهن وليس المراد من قوله لا يتصور وجوده الوجود الذهني بل الخارجي وهذا حق وجوابه أن لا نسلم أن كل ما لا يتصور وجوده في الخارج لا يطلب وهل النزاع إلا فيه
قال غير واقع بالممتنع لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق
اختلف القائلون بجواز التكليف بالمحال في وقوعه فذهب الجمهور إلى عدم وقوعه والمختار عند المصنف التفصيل الذي ذكره وهو عدم الوقوع بالممتنع لذاته كقلب الحقائق مع بقاء الحقيقة الأولى وإعدام القديم هذا ما ذكره وهو يفهم وقوع الممتنع لغيره والحق فيه التفصيل أيضا فإن كان مما قضت العادة بامتناعه كحمل الصخرة العظيمة للرجل النحيف فحكمه حكم الممتنع لذاته في الجواز وعدم الوقوع وأما ما امتنع لتعلق العلم به فذاك ليس محل النزاع بل هو واقع بالإجماع كما سلف
فائدة قد عرفت ما عليه جمهور الأصحاب من تجويز للتكليف بالمحال واختلافهم في الوقوع على الوجه الذي رأيت فأما التجويز فهو المنقول عن أبي الحسن وهو لازم على قضايا مذهبه وأما الوقوع فقد نقلوا اختلافا عنه فيه
قال إمام الحرمين وهذا لسوء معرفة مذهب الرجل فإن مقتضى مذهبه أن التكاليف كلها واقعة عنده على خلاف الاستطاعة
قال ويتقرر هذا من وجهين
أحدهما أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل والأمر بالفعل يتوجه على المكلف قبل وقوعه وهو إذ ذاك غير مستطع قال ولا يدفع ذلك قول القائل إن الأمر بالفعل نهي عن أضداده والمأمور بالفعل قبل الفعل إن لم يكن قادرا على الفعل فهو قادر على ضد من أضداده ملابس له فإنا سنوضح أن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن اضداده قال وأيضا فإن القدرة إذا قارنت الضد لم تقارن الأمر بالفعل والفعل مقصود مأمور به وقد تحقق طلبه قبل القدرة عليه
والثاني أن القدرة الحادثة غير مؤثرة في مقدورها بل مقدورها مخلوق الله تعالى والعبد مطالب بما هو من فعل ربه قال ولا معنى للتمويه بالكسب فإنا سنوضح سر ما نعتقده في خلق الأفعال انتهى
ولقائل أن يقول على الأول قولكم ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده قلنا الكلام على رأي الشيخ وهو يرى ذلك لا على رأيكم قال صفي الدين الهندي بل الجواب عنه أن ما هو متلبس به عند ورود الخطاب ليس ضدا له وهو الآن ضده الوجودي المنهي عنه وهو الذي يستلزم للتلبس به تركه في الزمان الذي أمر بإيقاع الفعل فيه وهو في زمان ورود الخطاب لم يتلبس به لأن زمان الفعل هو الزمان الثاني إن كان الأمر للفور سلمنا أن ذلك ضده المنهي عنه لكنه حاصل عند ورود الخطاب والأمر بترك الحاصل محال اللهم إلا أن يقال إنه مأمور بترك ما هو متلبس به في المستقبل وذلك إنما يكون بإقدامه على المأمور به وحينئذ يعود المحذور المذكور
واعلم أن الوجه الأول لا يلزم على الشيخ إلا إذا قال بتوجه الأمر قبل الفعل وفيه ما تقدم من النزاع في المسألة المتقدمة وأما الوجه الثاني فلا يلزم تجويز التكليف بالممتنع لذاته أو الممتنع عادة
أدلة القائلين بعدم الوقوع
قال للإستقراء ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعهااستدل على أنه غير واقع بالممتنع لذاته بوجهين
أحدهما الاستقراء فإنا استقرينا فلم نجد في التكاليف الشرعية ما هو متعلق بالممتنع لذاته
والثاني قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والممتنع لذاته غير وسع المكلف أي غير مقدور له فلا يكلف به ولك أن تقول هذه الآية تدل على عدم التكليف بالممتنع لذاته والممتنع لغيره لا الممتنع لذاته فقط فيلزم من استدل بها منع الوقوع فيهما ما لم يأت بدليل يخرج الممتنع لغيره
دليل القائلين بالوقوع
قيل أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل ومنه أنه لا يؤمن فهو جمع بين النقيضين قلنا لا نسلم أنه أمر به بعد ما أنزل أنه لا يؤمنهذا دليل القائلين بوقوع التكليف بالمحال لذاته ويصلح أن يكون اعتراضا على الدليل الأول وهو الاستقراء وتقريره أن أبا لهب مأمور بالجمع بين التقيضين لأنه مأمور بالإيمان والإيمان عبارة عن تصديق النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك ولا يتم تصديقه في ذلك إلا بعدم الإيمان فوجب أن يؤمن وأن لا يؤمن وهو جمع بين النقيضين
وأجاب بأن أمر أبي لهب بالإيمان لم يكن في حال الإخبار بعدم الإيمان بحسب الزمان فلم يقع التكليف بالجمع بين النقيضين وهو جواب باطل فإن أبا لهب مأمور بالإيمان قبل الإخبار وبعده الإجماع وإنما الجواب أن هذا ليس من باب الممتنع لذاته بل من الممتنع لغيره وذلك أنه تعالى أخبر أنه لا يؤمن فاستحال إيمانه ضررورة صدق خبر الله تعالى وعدم وقوع الخلف في خبره فإذا أمره بالإيمان والحالة هذه فقد أمره بما هو ممكن في نفسه وإن كان مستحيلا لغيره كما قلناه فيمن علم أنه لا يؤمن وها هنا تنبيهان
أحدهما وذكره القرافي أن الجمع بين النقيضين على ما قرروه إنما يتم أن لو كان مكلفا بأن يؤمن وبأن لا يؤمن وهو ليس بجيد بل الصواب حذف الواو فيقال كلف بأن يؤمن بأن لا يؤمن وهو مدلول الأمر بالإيمان وإذا كان مكلفا بأن يصدق الخبر بأنه لا يؤمن لا يلزم أن يكون مكلفا بجعل الخبر صادقا ألا ترى أن الصادق إذا أخبرك أن زيدا سيكفر بالله غذا فإنه يجب عليك تصديقه فيما أخبر به ولا يجب عليك أن تجعل زيدا كافرا بل يحرم عليك وأبو لهب والحالة هذه إنما كلف بأن يصدق بأنه لا يؤمن إلا بأن يجعل الخبر صادقا ويسعى في عدم إيمان نفسه
والثاني تعبير المصنف بالنقيضين غير مستقيم فإنه نظر إلى وقوع التكليف بالإيمان وعدمه وهما نقيضان ولكن العدم غير مقدور عليه فلا يكلف به بل المكلف به على التقدير الذي أشار إليه كف النفس عن الإيمان والكف فعل وجودي فالصواب التعبير بالضدين كما فعل الإمام
فائدة ناقش القرافي في التمثيل بأبي لهب وقال إنما يتوهم أن الله أخبر بعدم إيمانه من قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ولا دليل فيه لأن التب هو الخسران وقد يخسر الإنسان ويدخل النار وهو مؤمن لمعاصيه وأما قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فمخصوصة ولقائل أن يقول لا مشاحة في المثال ولا شك أنه تعالى أخبر عن أقوام أنهم لا يؤمنون من الآية التي ذكرها وإن كانت مخصوصة وذلك كاف في المثال فإن أولئك الذين أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون مأمورون بالإيمان إجماعا بل لمن يشاحح القرافي أن يقول إخباره تعالى عن أبي لهب أنه سيصلى نارا أقل أحواله أن يكون صليه إياها بمعاص صدرت منه كما ذكرتم والآية نزلت وهو كافر فيكون العقاب على معاص تصدر منه في حال الكفر فنقول حينئذ إن قلنا إن الكافر غير مكلف بالفروع فهذا منتصف ولا بد أن تكون النار التي استوجبها بعدم الإيمان وإن قلنا أنه مكلف فلو قدر إسلامه بعد ذلك كما فرضتم لكان غير معاقب على تلك المعاصي التي صدرت منه في حال الكفر لأن الإسلام يجب ما قبله فتعين أن يكون العقاب على ترك الإيمان وهو المطلوب