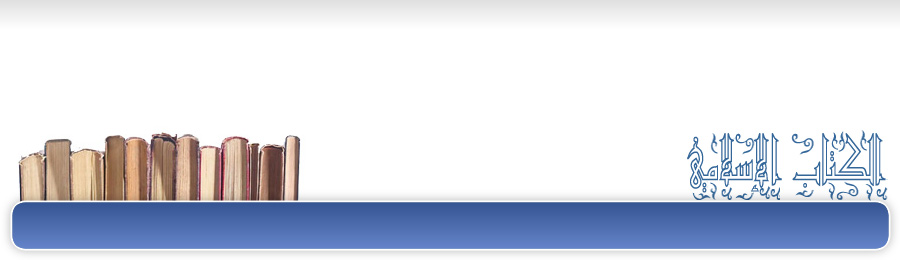كتاب : البرهان في علوم القرآن
المؤلف : بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي
فإنه قد قيل: ظاهره نفى وجود الهم منهم بإضلاله وهو خلاف الواقع فإنهم هموا وردوا القول.
وقيل: قوله: {لَهَمَّتْ} ليس جواب [لو] بل هو كلام تقدم على [لو] وجوابها مقول على طريق القسم وجواب [لو] محذوف تقديره: {لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ} لولا فضل الله عليك لأضلوك.
وقوله: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَبِّهِ}، أي همت بمخالطته وجواب [لولا] محذوف، أي لولا أن رأى برهان ربه لخالطها.
وقيل: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، والوقف على هذا {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ} والمعنى أنه لم يهم بها.
ذكره أبو البقاء والأول للزمخشري.
ولا يجوز تقديم جواب [لو] عليها لأنه في حكم الشرط وللشرط صدر الكلام.
وقوله: {وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ} جواب الشرط محذوف يدل عليه قوله: {إِنَّا لَمُهْتَدُون} أي إن شاء الله اهتدينا.
وقد توسط الشرط هنا بين جزأي الجملة بالجزاء لأن التقديم على الشرط فيكون دليل الجواب متقدما على الشرط والذي حسن تقديم الشرط عليه الاهتمام بتعليق الهداية بمشيئة الله تعالى.
وقوله تعالى: {لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ} تقديره: لما استعجلوا فقالوا متى هذا الوعد.
وقال الزجاج: تقديره [لعلموا صدق الوعد] لأنهم قالوا: متى هذا الوعد وجعل الله الساعة موعدهم فقال تعالى: {بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً}.
وقيل: تقديره: [لما أقاموا على كفرهم ولندموا أو تابوا].
وقوله في سورة التكاثر: {لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ} تقديره لما: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ}.
وقيل: تقديره: لشغلكم ذلك عما أنتم فيه.
وقيل: لرجعتم عن كفركم أو لتحققتم مصداق ما تحذرونه.
وقوله: {قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً} أي لا يتبعونهم.
وقوله: {قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ، تقديره: [لآمنتم] أو [لما كفرتم] أو [لزهدتم في الدنيا] أو [لتأهبتم للقائنا].
ونحوه: {وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ}، أي يهتدون في الدنيا لما رأوا العذاب في الاخرة أو لما اتبعوهم.
وقوله: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} ، قال محمد بن إسحاق: معناه لو أن لي قوة لحلت بينكم وبين المعصية.
وقوله تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ} أي رأيت ما يعتبر به عبرة عظيمة.
وقوله عقب آية اللعان: {وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ}، قال الواحدي: قال الفراء: جواب لو محذوف لأنه معلوم المعنى وكل ما علم فإن العرب تكتفي بترك جوابه ألا ترى أن الرجل يشتم الرجل فيقول المشتوم: أما والله لولا أبوك.. فيعلم أنك تريد: لشتمتك.
وقال المبرد: تأويله والله أعلم: لهلكتم أو لم يبق لكم باقية أو لم يصلح أمركم ونحوه من الوعيد الموجع فحذف لأنه لا يشكل.
وقال الزجاج: المعنى لنال الكاذب منكم أمر عظيم وهذا أجود مما قدره المبرد.
وكذلك [لولا] التي بعدها في قوله تعالى: {وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ}، جوابها محذوف وقدره بعضهم في الأولى لافتضح فاعل ذلك وفي الثانية: لعجل عذاب فاعل ذلك وسوغ الحذف طول الكلام بالمعطوف والطول داع للحذف.
وقوله: {وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ} جوابها محذوف أي لولا احتجاجهم بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة.
وقال مقاتل: تقديره: لأصابتهم مصيبة.
وقال الزجاج: لولا ذلك لم يحتج إلى إرسال الرسول ومواترة الاحتجاج.
وقوله: {وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا} أي لأبدت.
وقوله تعالى:{ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي}، تقديره: لو تملكون، [تملكون] فأضمر [تملك] الأولى على شريطة التفسير وابدل من الضمير المتصل الذي هو [الواو] ضمير منفصل وهو [أنتم] لسقوط ما يتصل به من الكلام فـ[أنتم] فاعل الفعل المضمر [وتملكون] تفسيره.
وقال الزمخشري: هذا ما يقتضيه الإعراب فأما ما يقتضيه علم البيان فهو أن [أنتم] تملكون فيه دلالة على الاختصاص وأن الناس هم المختصون بالشح المتتابع وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر.
ومن حذف الجواب قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، أي أعرضوا ؟ بدليل قوله بعده:{إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ} وقوله في قصة إبراهيم في الحجر: {فَقَالُوا سَلاماً قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ} وفي غيرها من السور: {قَالُوا سَلاماً} {قَالَ سَلامٌ} قال الكرماني: لأن هذه السورة متأخرة عن الأولى فاكتفى بما في هذه ولو ثبت تعدد الوقائع لنزلت على واقعتين.
وكقوله تعالى: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} قال الزمخشري حذف الجواب وتقديره مصرح به في سورتي التكوير والانفطار وهو قوله: {عَلِمَتْ نَفْسٌ}.
وقال في: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ}: الجواب محذوف أي أنهم ملعونون يدل عليه قوله: {قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ}.
وكقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} أي [حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها] والواو واو وحال وفي هذا ما حكى أنه اجتمع أبو علي الفارسي مع ابي عبد الله الحسين بن خالويه في مجلس سيف الدولة فسئل ابن خالويه عن قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا}، في النار بغير واو، وفي الجنة بالواو! فقال ابن خالويه: هذه الواو تسمى واو الثمانية لأن العرب لا تعطف الثمانية إلا بالواو قال: فنظر سيف الدولة إلى أبي علي وقال أحق هذا فقال أبو علي: لا أقول كما قال إنما تركت الواو في النار لأنها مغلقة وكان مجيئهم شرطا في فتحها فقوله:{ فُتِحَتْ} فيه معنى الشرط وأما قوله:{ وَفُتِحَتْ} في الجنة فهذه واو الحال كأنه قال جاءوها وهي مفتحة الأبواب أو هذه حالها.
وهذا الذي قاله أبو علي هو الصواب ويشهد له أمران:.
أحدهما : أن العادة مطردة شاهدة في إهانة المعذبين بالسجون من إغلاقها حتى يردوا عليها وإكرام المنعمين بإعداد فتح الأبواب لهم مبادرة واهتماما.
والثاني: النظير في قوله: {جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ}.
وللنحويين في الآية ثلاثة أقوال:.
أحدها: أن الواو زائدة والجواب قوله: [فتحت] وهؤلاء قسمان منهم من جعل هذه الواو مع أنها زائدة واو الثمانية ومنهم من لم يثبتها.
والثاني: أن الجواب محذوف عطف عليه قوله: [وفتحت] كأنه قال:{حتى إذا جاءوها [جاءوها] وفتحت} قال الزجاج وغيره: وفي هذا حذف المعطوف وإبقاء المعطوف عليه.
والثالث: أن الجواب محذوف آخر الكلام كأنه قال بعد الفراغ استقروا أو خلدوا أواستووا مما يقتضه المقام وليس فيه حذف معطوف ويحتمل أن يكون التقدير إذا جاءوها إذن لهم في دخولها وفتحت أبوابها المجىء ليس سببا مباشرا للفتح بل الإذن في الدخول هو السبب في ذلك.
وكذلك قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا} ، أي رحمهم ثم تاب عليهم وهذا التأويل أحسن من القول بزيادة [ثم].
وحذف المعطوف عليه وإبقاء المعطوف سائغ، كقوله تعالى: {فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً}، التقدير والله أعلم: فذهبا فبلغا فكذبا فدمرناهم لأن المعنى يرشد إلى ذلك.
وكذا قوله تعالى: {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ}، أي فامتثلتم أو فعلتم فتاب عليكم.
وقوله: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ} أي رحما وسعدا وتله وابن عطية يجعل التقدير فلما أسلما اسلما وهو مشكل.
وقوله: {وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا} ، المعنى: حتى إذا كان ذلك ندم الذين كفروا ولم ينفعهم إيمانهم لأنه من الآيات والأشراط.
وقد يجيء في الكلام شرطان ويحذف جواب أحدهما اكتفاء بالآخر كقوله تعالى: {وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ} في الاعتراض به مجرى الظرف لأن الشرط وإن كان جملة فإنه لما لم يقم بنفسه جرى مجرى الجزء الواحد ولو كان عنده جملة لما جاز الفصل به بين [أما] وجوابها لأنه لا يجوز. أما زيد فمنطلق وذهب الأخفش إلى أن الفاء جواب لهما.
ونظيره: {وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَأُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ} فقوله:[ لَعَذَّبْنَا ]جواب للولا ولو جميعا.
واختار ابن مالك قول سيبويه أن الجواب [لأما] واستغنى به عن جواب [إن] لأن الجواب الأول الشرطين المتواليين في قوله: {إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ} ونظائره.
فإذا كان أول الشرطين [أما[ كانت أحق بذلك لوجهين:.
أحدهما: أن جوابها إذا انفردت لا يحذف أصلا وجواب غيرها إذا انفرد يحذف كثيرا لدليل وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم يعهد.
والثاني: أن أما قد التزم معها حذف فعل الشرط وقامت هي مقامة فلو حذف جوابها لكان ذلك إجحافا وإن ليس كذلك انتهى.
والظاهر أنه لا حذف في الآية الكريمة وإما الشرط الثاني وجوابه جواب الأول والمحذوف إنما هو أحد الفاءين.
وقال الفارسي في قوله تعالى: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ} الآية. إنه حذف منه أعزنا ولا تذلنا.
وقال في قوله تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ}، تقديره:[ فكيف تجدونهم مسرورين أو محزونين] فـ "كيف" في موضع نصب بهذا الفعل المضمر وهذا الفعل المضمر قد سد مسد جواب إذا.
حذف جواب القسم.
لعلم السامع المراد منه كقوله تعالى: {وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً يوم ترجف الراجفة}، تقديره: لتبعثن ولتحاسبن بدليل إنكارهم للبعث في قولهم: {أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ}.
وقيل: القسم وقع على قوله: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى}.
وكقوله تعالى: {لَنْ نُؤْثِرَكَ} وحذف لدلالة الكلام السابق عليه.
واختلف في جواب القسم في: {ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ} فقال الزجاج: {إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ}، واستبعده الكسائي.
وقال الفراء: قد تأخر كثيرا وجرت بينهما قصص مختلفة فلا يستقيم ذلك في العربية.
وقيل: {كَمْ أَهْلَكْنَا} ومعناه: لكم أهلكنا وما بينهما اعتراض وحذفت اللام لطول الكلام.
وقال الأخفش: {إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ} والمعترض بينهما قصة واحدة.
وعن قتادة: {بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ} ، مثل: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا}.
وقال صاحب النظم في هذا القول: معنى "بل" توكيد الأمر بعده فصار مثل أن الشديدة تثبت ما بعدها وإن كان لها معنى آخر في نفي خبر متقدم كأنه قال: إن الذين كفروا في عزة وشقاق.
وقال أبو القاسم الزجاجي: إن النحويين قالوا: إن "بل" تقع في جواب القسم كما تقع "إن" لأن المراد بها توكيد الخبر وذلك في {ص وَالْقُرْآنِ} الآية. وفي: {ق وَالْقُرْآنِ} الآية. وهذا من طريق الاعتبار ويصلح أن يكون بمعنى "إن" لأنه سائغ في كلامهم أو يكون "بل" جوابا للقسم لكن لما كانت متضمنة رفع خبر وإتيان خبر بعده كانت أوكد من سائر التوكيدات فحسن وضعها موضع "إن".
وقيل: الجواب محذوف أي والقرآن المجيد ما الأمر كما يقول هؤلاء أو الحق ما جاء به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقال الفراء في قوله تعالى: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} جوابه محذوف أي فيومئذ يلاقي حسابه.
وعن قتاده أن جوابه: {وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ} يعني أن الواو فيها بمعنى السقوط كقوله تعالى: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ} ، أي ناديناه.
حذف الجملة.
هي أقسام: قسم هي مسببة عن المذكور وقسم هي سبب له وقسم خارج عنها، فالأول: كقوله تعالى: {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ} فإن اللام الداخلة على الفعل لا بد لها من متعلق يكون سببا عن مدخول اللام فلما لم يوجد لها متعلق في الظاهر وجب تقديره ضرورة فيقدر: فعل ما فعل ليحق الحق.
والثاني: كقوله تعالى: {فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً}، فإن الفاء إنما تدخل على شيء مسبب عن شيء ولا مسبب إلا له سبب فإذا وجد المسبب - ولا سبب له ظاهرا - أوجب أن يقدر ضرورة فيقدر: فضربه فانفجر.
والثالث: كقوله تعالى: {فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} أي نحن هم أو هم نحن.
وقد يكون المحذوف أكثر من جملةكقوله تعالى: {فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ} الآية. فإن التقدير:" فأرسلون إلى يوسف لأستعبره الرؤيا فأرسلوه إليه لذلك فجاء فقال له:.
يا يوسف" وإنما قلنا إن هذا الكل محذوف لأن قوله: {أَرْسِلُونِ} يدل لا محالة على المرسل إليه فثبت أن "إلى يوسف" محذوف ثم إنه لما طلب الإرسال إلى يوسف عند العجز الحاصل للمعبرين عن تعبير رؤيا الملك دل ذلك على أن المقصود من طلب الإرسال إليه استعباره الرؤيا التي عجزوا عن تعبيرها ومنه قوله تعالى:{اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ} الآية، فأعقب بقوله حكاية عنها: {قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ}، تقديره: فأخذ الكتاب فألقاه إليهم فرأته بلقيس وقرأته و{قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ}.
وقوله: {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً} حذف يطول تقديره: فلما ولد يحيى ونشأ وترعرع قلنا: {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ}.
ومنه قوله تعالى حكاية عن قوم موسى: {لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي}.
وقوله: {فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ} إلى قوله: {نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا}.
وقوله: {أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ} أي كمن قسا قلبه ترك على ظلمه وكفره ودل على المحذوف قوله: {فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ}.
ومن حذف الجملة قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا} قيل: المعنى جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا وكذا وإلا فمن أين علم الملائكة أنهم يفسدون وباقي الكلام يدل على المحذوف.
وقوله: {يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ}، قال
الفارسي: المعنى فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة:" واتقوا الله" عطف على قوله:" فاكرهوا" إن لم يذكر لدلالة الكلام عليه كقوله تعالى:" فانفجرت" أي فضرب فانفجرت فقوله:" كرهتموه" كلام مستأنف وإنما دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الجواب لأن قوله:" أيحب أحدكم" كأنهم قالوا في جوابه لا، فقال: فكرهتموه أي فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة.
قال ابن الشجري: وهذا التقدير بعيد لأنه قدر المحذوف موصولا وهو "ما" المصدرية وحذف الموصول وإبقاء صلته ضعيف وإنما التقدير فهذا كرهتموه والجملة المقدرة المحذوفة ابتدائية لا أمرية والمعنى فهذا كرهتموه والغيبة مثله وإنما قدرها أمرية ليعطف عليها الجملة الأمرية في قوله:" واتقوا الله".
حذف القول.
قد كثر في القرآن العظيم حتى إنه في الإضمار بمنزلة الإظهار كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}، أي يقولون: ما نعبدهم إلا للقربة.
ومنه: {وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا} أي وقلنا كلوا أو قائلين.
وقوله: {عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا} أي قلنا.
{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا} أي وقلنا خذوا.
{وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} أي وقلنا: اتخذوا.
وقوله: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا} أي يقولان: ربنا وعليه قراءة عبد الله.
{فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ} أي فيقال لهم لأن أما لا بد لها في الخبر من فاء فلما أضمر القول أضمر الفاء.
وقوله: {وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ} يقال لهم هذا.
وقوله: {وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ} أي يقولون سلام.
وقوله: {تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ} أي يقولون لهم ذلك.
وقوله: {الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ} أي يقولون ما نعبدهم.
وقوله: {فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ} أي يقولون إنا لمغرمون أي معذبون وتفكهون: تندمون.
وقوله: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا} أي يقولون ربنا
وقوله: { مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ} أي قالوا قال الحق.
حذف الفعل.
وينقسم إلى عام وخاص:.
الخاص
فالخاص نحو: أعنى مضمرا وينتصب المفعول به في المدح نحو: {وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ} ، وقوله: {وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} أي أمدح.
واعلم أنه إذا كان المنعوت متعينا لم يجز تقديره ناصب نعته بأعنى نحو الحمد لله الحميد بل المقدر فيه وفي نحوه أذكر أو أمدح فاعرف ذلك والذم نحو قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} في قراءة النصب والأخفش ينصب في المدح بأمدح وفي الذم بأذم.
وأعلم أن مراد المادح إبانة الممدوح من غيره فلا بد من إبانة إعرابه عن غيره ليدل اللفظ على المعنى المقصود ويجوز فيه النصب بتقدير أمدح والرفع على معنى "هو" ولا يظهران لئلا يصيرا بمنزلة الخبر.
والذي لا مدح فيه فاختزال العامل فيه واجب كاختزاله في والله لأفعلن إذ لو قيل: أحلف بالله لكان عدة لا قسما.
العام.
والعام كل منصوب دل عليه الفعل لفظا أو معنى أو تقديرا ويحذف لأسباب:.
أحدها: أن يكون مفسرا، كقوله تعالى: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}،{وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ}.
ومنه: {أَبَشَراً مِنَّا وَاحِداً نَتَّبِعُهُ} {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا} {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} {وَإِنْ طَائِفَتَانِ} فإنه ارتفع "باقتتل" مقدرا.
قالوا: ولا يجوز حذف الفعل مع شيء من حروف الشرط العاملة سوى "إن" لأنها الأصل.
وجعل ابن الزملكاني هذا مما هو دائر بين الحذف والذكر فإن الفعل المفسر كالمتسلط على المذكور ولكن لا يتعين إلا بعد تقدم إبهام ولقد يزيده الإضمار إبهاما إذا لم يكن المضمر من جنس الملفوظ به نحو: {وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً}.
الثاني: أن يكون هناك حرف جر نحو: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فإنه يفيد.
أن المراد: بسم الله أقرأ أو أقوم أو أقعد عند القراءة وعند الشروع في القيام أو القعود أي فعل كان.
واعلم ان النحاة اتفقوا على أن بسم الله بعض جملة واختلفوا.
فقال البصريون: الجملة اسمية أي ابتدائي بسم الله.
وقال الكوفيون: الجملة فعلية وتابعهم الزمخشري في تقدير الجملة فعلية ولكن خالفهم في موضعين: أحدهما: أنهم يقدرون الفعل مقدما وهو يقدره مؤخرا. والثاني: أنهم يقدرونه فعل البداية وهو يقدره في كل موضع بحسبه فإذا قال الذابح: بسم الله كان التقدير: بسم الله أذبح وإذا قال القارىء: بسم الله فالتقدير: بسم الله أقرأ.
وما قال أجود مما قالوا لأن مراعاة المناسبة أولى من إهمالها ولأن اسم الله أهم من الفعل فكان أولى بالتقديم ومما يدل على ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " باسمك ربي وضعت " ، جنبي فقدم اسم الله على الفعل المتعلق ثم الجار وهو "وضعت".
الثالث: أن يكون جوابا لسؤال وقع، كقوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} وقوله: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} وقوله: {وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} أي بل نتبع.
أو جوابا لسؤال مقدر كقراءة: {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ} ببناء الفعل للمفعول فإن التقدير: يسبحه رجال.
وفيه فوائد: منها: الإخبار بالفعل مرتين. ومنها جعل الفضلة عمدة.
ومنها: أن الفاعل فسر بعد اليأس منه كضالة وجدها بعد اليأس، ويصح أن يكون "يُسَبَّح" بدل من "يُذْكَر"على طريقة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} و"له فيها" خبر مبتدأ هو "رجال".
مثله قراءة من قرأ: {زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ} ، قال أبو العباس: المعنى زينه شركاؤهم فيرفع الشركاء بفعل مضمر دل عليه "زين".
ومثله قوله تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ} إن جعلنا قوله "لله شركاء" مفعولي "جعلوا" لأن لله في موضع الخبر المنسوخ وشركاء نصب في موضع المبتدأ وعلى هذا فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون مفعولا بفعل محذوف دل عليه سؤال مقدر كأنه قيل: أجعلوا لله شركاء قيل جعلوا الجن فيفيد الكلام إنكار الشريك مطلقا فدخل اعتقاد الشريك من غير الجن في إنكار دخول اتخاذه من الجن.
والثاني: ذكره الزمخشري أن الجن بدل من "شركاء" فيفيد إنكار الشريك مطلقا كما سبق وإن جعل "لله" صلة كان "شركاء الجن" مفعولين قدم ثانيهما على أولهما وعلى هذا فلا حذف.
فأما على الوجه الأول فقيل: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ} ولم يقل: "وجعلوا.
الجن شركاء لله" تعظيما لاسم الله تعالى لأن شأن الله أعظم في النفوس فإذا قدم "لله" والكلام فيه يستدعي طلب المجعول له ما هو؟ فقيل: شركاء وقع في غاية التشنيع لأن النفس منتظرة لهذا المهم المعلق بهذا المعظم نهاية التعظيم فإذا علم أنه علق به هذا المستبشع في النهاية كان أعظم موقعا من العكس لأنه إذا قيل: وجعلوا شركاء لم يعطه تشوف النفوس لجواز أن يكون: جعلوا شركاء في أموالهم وصدقاتهم أو غير ذلك.
الثالث: أن الجعل غالبا لا يتعلق بالله ويخبر به إلا وهو جعل مستقبح كاذب إذ لا يستعمل جعل الله رحمة ومشيئة وعلما ونحوه لا سيما بالاستقراء القرآني كـ {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ} {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ} إلى غير ذلك.
الرابع: أن أصل الجعل وإن جاز وإسناده إلى الله فيما إذا كان الأمر لائقا فإن بابه مهول لأن الله تعالى قد علمنا عظيم خطره وألا نقول فيه إلا بالعلم كقوله: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} {وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً}، إلى غير ذلك، مع ما دل عليه الأدب عقلا وكان نفس الجعل مستنكرا إن لم يتبع بمجعول لائق فإذا أتبع بمجعول غير لائق منهم ثم فسر بخاص مستنكر صار قوله: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ} في قوة إنكار ذلك ثلاث مرات الأول جسارتهم في أصل الجعل الثاني في كون المجعول شركاء الثالث في أنهم شركاء جن.
الخامس: أن في تقديم "لله" إفادة تخصيصهم إياه بالشركة على الوجه الثالث دون جميع ما يعبدون لأنه الإله الحق.
السادس: أنه جيء بكلمة "جعلوا" لا "اعتقدوا" ولا "قالوا" لأنه أدل على إثبات المعتقد لأنه يستعمل في الخلق والإبداع.
السابع: كلمة "شركاء" ولم يقل: شريكا، وفاقا لمزيد ما فتحوا من اعتقادهم.
الثامن: لم يقل "جنا" وإنما قال: الجن، دلالة على أنهم اتخذوا الجن كلها جعلوه من حيث هو صالح لذلك وهو أقبح من التنكير الذي وضعه للمفردات المعدولة.
الرابع: أن يدل عليه معنى الفعل الظاهر، كقوله تعالى: {انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ} أي وائتوا أمرا خيرا لكم فعند سيبويه أن "خيرا" انتصب بإضمار ائت لأنه لما نهاء علم أنه يأمره بما هو خير فكأنه قال:" وائتوا خيرا" لأن النهي عن الشيء أمر بضده ولأن النهي تكليف وتكليف العدم محال لأنه ليس مقدورا فثبت أن متعلق التكليف أمر وجودي ينافي المنهى عنه وهو الضد.
وحمله الكسائي على إضمار كان أي يكن الانتهاء خيرا لكم ويمنعه إضمار كان ولا تضمر في كل موضع ومن جهة المعنى إذ من ترك ما نهى عنه فقد سقط عنه اللوم وعلم أن ترك المنهي عنه خير من فعله فلا فائدة في قوله "خيرا".
وحمله الفراء على أنه صفة لمصدر محذوف أي انتهوا انتهاء خيرا لكم وقال إن هذا الحذف لم يأت إلا فيما كان أفعل نحو خير لك، وأفعل.
ورد مذهبه ومذهب الكسائي بقوله تعالى: {وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً} لو حمل على ما قالا لا يكون خيرا لأن من انتهى عن التثليث وكان معطلا لا يكون خيرا له. وقول سيبويه: وأنت خيرا يكون أمرا بالتوحيد الذي هو خير فلله در الخليل وسيبويه ما أطلعهما على المعاني !.
وقوله: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} إن لم يجعل مفعولا معه أي وادعوا شركاءكم وبإظهار "ادعوا" قرأ وكذلك هو مثبت في مصحف ابن مسعود.
وقوله تعالى: {فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ}، قال ابن الشجري: معناه مال عليهم بضربهم ضربا. ويجوز نصبه على الحال نحو أتيته مشيا أي ماشيا.
{ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً} أي ساعيات. وقوله: "باليمين" إما اليد أو القوة.
وجوز ابن الشجري إرادة القسم والباء للتعليل أي لليمين التي حلفها وهي قوله تعالى: {لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ}.
وزعم النووي في قوله تعالى: { قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ} ، أن التقدير ليكن منكم طاعة معروفة.
الخامس: أن يدل عليه العقل، كقوله تعالى: {فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ} أي فضرب فانفجرت.
وقوله: {فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. فَفَتَحْنَا} قال النحاس: التقدير فنصرناه ففتحنا أبواب السماء لأن ما ظهر من الكلام يدل على ما حذف.
وقوله: {يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ} أي يكتب بذلك كلمات الله ما نفدت قاله أبو الفتح.
وقوله: {فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ}.
فقوله:" ثم أحياهم "معطوف على فعل محذوف تقديره فماتوا ثم أحياهم ولا يصح.
عطف قوله:" ثم أحياهم " على قوله:" موتوا " لأنه أمر وفعل الأمر لا يعطف على الماضي.
وقوله: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ} أي فاختلفوا فبعث وحذف لدلالة قوله: {لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} وهي في قراءة عبد الله كذلك.
وقيل: تقديره كان الناس أمة واحدة كفارا فبعث الله النبيين فاختلفوا والأول أوجه.
وقوله: {أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ} فالهمزة للإنكار والواو للعطف والمعطوف عليه محذوف تقديره: أكذبتم وعجبتم أن جاءكم.
وقوله: {قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ} ، هو معطوف على محذوف سد مسده حرف الإيجاب كأنه قال إيجابا لقولهم: {نَّ لَنَا لأَجْراً} ، نعم إن لكم أجرا وإنكم لمن المقربين.
وقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ}، أي فأفطر فعدة، خلافا للظاهرية حيث أوجبوا الفطر على المسافر أخذا من الظاهر.
وقوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَة}، أي فحلق ففدية.
وقوله: {فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا} قال الزمخشري: التقدير فضربوه فحيى.
فحذف ذلك لدلالة قوله: {كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى}.
وزعم ابن جنى أن التقدير في قوله تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ} أن التقدير فكيف يكون إذا جئنا.
السادس: أن يدل عليه ذكره في موضع آخر، كقوله: {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً}، قال الواحدي: هو بإضمار "اذكر" ولهذا لم يأت لإذ بجواب. ومثله قوله تعالى: {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً} وليس شيء قبله تراه ناصبا لـ"صالحا"، بل علم بذكر النبي والمرسل إليه أن فيه إضمار" أرسلنا ".
وقوله: {وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ} أي وسخرنا.
ومثله: {وَنُوحاً إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ} {وَذَا النُّونِ}.
وكذا: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ}، أي واذكر.
قال: ويدل على "اذكر" في هذه الآيات قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ} {وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ}.
وما قاله ظاهر، إلا أن مفعول "اذكر" يكون محذوفا أيضا تقديره:" واذكروا أخالكم "ونحوه إذا كان كذا وذلك ليكون "إذ" في موضع نصب على الظرف ولو لم يفد ذلك المحذوف لزم وقوع "إذ" مفعولا به والأصح أنها لا تفارق الظرفية.
السابع: المشاكلة كحذف الفاعل في" بسم الله "لأنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله فلو ذكر الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود وكان في حذفة مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله كما تقول في الصلاة الله أكبر ومعناه:" من كل شيء "ولكن لا تقول هذا المقدر ليكون اللفظ في اللسان مطابقا لمقصود الجنان وهو أن يكون في القلب ذكر الله وحده وأيضا فلأن الحذف أعم من الذكر فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه لأن التسمية تشرع عند كل فعل.
الثامن: أن يكون بدلا من مصدره، كقوله تعالى: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} وقوله: {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} أي فإما أن تمنوا وإما أن تفادوا.
وقد اختلف في نصب السلام في قوله تعالى في سورة هود: {وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلاماً} وفي الذاريات: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاماً} وفي نصبها وجهان:.
أحدهما: أن يكون منصوبا بالقول أي يذكرون قولا سلاما فيكون من قلت حقا وصدقا.
الثاني: أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره فقالوا سلمنا سلاما أي سلمنا تسليما فيكون قد حكى الجملة بعد القول ثم حذفها واكتفى ببعضها.
والحاصل أنه هل هو منصوب بالقول أو بكونه مصدر لفعل محذوف ؟.
ومثله قوله تعالى: {وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً}.
منصوب "بقالوا" كقولك فقلت حقا أو منصوب بفعل مضمر أي قالوا: أنزل خيرا من باب حذف الجملة المحكية وتبقية بعضها.
وأما قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ} فمرفوع لأنه لا يمكن نصبه على تقدير قالوا أساطير الأولين لأنهم لم يكونوا يرونه من عند الله حتى يقولوا ذلك ولا هو أيضا من باب قلت حقا وصدقا فلم يبق إلا رفعه.
تنبيه:.
قد يشتبه الحال في أمر المحذوف وعدمه لعدم تحصيل معنى الفعل كما قالوا في قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} فإنه قد يظن أن الدعاء فيه بمعنى النداء فلا يقدر في الكلام حذف وليس كذلك وإلا لزم الاشتراك إن كانا متفاوتين أو عطف الشيء على نفسه وإنما الدعاء هنا بمعنى التسمية التي تتعدى لمفعولين أي سموه الله أو الرحمن.
قد يشتبه في تعيين المحذوف لقيام قرينتين كقوله تعالى: {بَلَى قَادِرِينَ} قدره سيبويه بـ"بلى نجمعها قادرين"، فقادرين حال وحذف الفعل لدلالة: {أَلَّنْ نَجْمَعَ} عليه.
وقدره الفراء " نحسب " لدلالة {أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ} أي بلى نحسبنا قادرين.
وتقدير سيبويه أولى لأن بلى ليس جوابا لـ"يحسب" إنما هو جواب لـ"ألن نجمع" وقدره بعضهم: بلى نقدر قادرين.
وقيل: منصوب لوقوعه موقع الفعل وهو باطل لأنه ليس من نواصب الاسم وقوعه موقع الفعل.
تنبيه آخر:.
إن الحذف على ضربين: أحدهما: ألا يقام شيء مقام المحذوف كما سبق والثاني: أن يقام مقامه ما يدل عليه كقوله تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ}، ليس الإبلاغ هو الجواب لتقدمه على قولهم، فالتقدير: فإن تولوا فلا ملام على لأني قد أبلغتكم.
وقوله: {وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ } فلا تحزن واصبر.
وقوله: {وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ} أي يصيبهم ما أصاب الأولين.
حذف الحرف.
قال أبو الفتح في" المحتسب ": أخبرنا أبو علي قال: قال أبو بكر بن السراج: حذف الحرف ليس يقاس وذلك لأن الحرف نائب عن الفعل بفاعله ألاتراك إذا قلت: ما قام زيد فقد نابت ما عن أنفي كما نابت إلا عن أستثنى وكما نابت الهمزة وهل عن أستفهم وكما نابت حروف العطف عن أعطف ونحو ذلك. فلو ذهبت.
تحذف الحرف لكان ذلك اختصارا واختصار المختصر إجحاف به إلا إذا صح التوجه إليه وقد جاز في بعض الأحوال حذفه لقوة الدلالة عليه. انتهى.
فمنه الواو تحذف لقصد البلاغة فإن في إثباتها ما يقتضى تغاير المتعاطفين فإذا حذفت أشعر بأن الكل كالواحد: كقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ} تقديره: ولا يألونكم خبالا.
وقوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ} أي ووجوه.
وخرج عليه الفارسي قوله تعالى: { وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا } الآية. وقال: تقديره: "وقلت لا أجد" فهو معطوف على قوله: "أتوك" لأن جواب "إذا" قوله: "تولوا".
ومنعه ابن الشجري في أماليه وعلى هذا فلا موضع له من الإعراب لأنه معطوف على الصلة والصلة لا موضع لها من الإعراب فكذلك ما عطف عليها.
وقال الزمخشري: هي حال من الكاف في" أتوك "، "وقد" قبله مضمرة كما في قوله: {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} أي إذا ما أتوك قائلا لا أجد تولوا وعلى هذا فله موضع من الإعراب لأنه حال.
قال السهيلي في أماليه: ليس معنى الآية كما قالوا لأن رفع الحرج عن القوم ليس مشروطا بالبكاء عند التولي وإنما شرطه عدم الجدة ونزلت في السبعة الذين سمى أبو إسحاق ولو كان جواب "إذا أتوك" في قوله: { تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ } لكان من لم تفض عيناه من الدمع هو الذي حرج وأثم وما رفع الله الحرج عنهم إلا لأن الرسول.
لم يجد ما يحملهم عليه وإذا عطفت "قلت لا أجد" على "أتوك" كان الحرج غير مرفوع عنهم حتى يقال: {وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ} فجواب إذا في قوله لا أجد وما بعد ذلك خبر ونبأ على هؤلاء السبعة الذين كانوا سبب نزول هذه الآية ففضيلة البكاء مخصوصة بهم ورفع الحرج بشرط عدم الجدة عام فيهم وفي غيرهم.
وقال الواحدي في قوله تعالى: {قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً}: آية البقرة في مصاحف الشام بغير واو - يعني قراءة ابن عامر - لأن هذه الآية ملابسة لما قبلها من قوله: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ} لأن القائلين:" اتخذ الله ولدا " من جملة المتقدم ذكرهم فيستغنى عن ذكر الواو لالتباس الجملة بما قبلها كما استغنى عنها في نحو قوله: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}، ولو كان وهم كان حسنا إلا أن التباس إحدى الجملتين بالأخرى وارتباطها بها أغنى عن الواو.
ومثله: {سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ} ولم يقل: ورابعهم كما قال: {وَثَامِنُهُمْ} ولو حذف الواو منها كما حذف من التي قبلها واستغنى عن الواو بالملابسة التي بينهما كان حسنا ويمكن أن يكون حذف الواو لاستئناف الجملة ولا يعطف على ما تقدم. انتهى.
وحصل من كلامه أنه عند حذف الواو يجوز أن يلاحظ معنى العطف ويكتفى للربط بينها وبين ما قبلها بالملابسة كما ذكر. ويجوز ألا يلاحظ ذلك فتكون الجملة مستأنفة.
قال ابن عمرون: وحذف الواو في الجمل أسهل منه في المفرد وقد كثر حذفها في الجمل.
في الكلام المحمول بعضه على بعض نحو قوله تعالى: {قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ } كله محمول بعضه على بعض والواو مزيدة حذفت لاستقلال الجمل بأنفسها بخلاف المفرد ولأنه في المفرد ربما أوقع لبسا في نحو: رأيت زيدا ورجلا عاقلا.، ولو جاز حذف الواو احتمل أن يكون رجلا بدلا بخلاف الجملة.
وقريب منه قوله تعالى: { فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ} أي وقال.
ومنه الفاء في جواب الشرط على رأى، وخرج عليه قوله تعالى: { إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ } أي فالوصية.
والفاء في العطف كقوله: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ }، تقديره: " فقال أعوذ بالله "ذكره ابن الشجري في أماليه.
وقوله تعالى: { وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ } حذف حرف العطف من قوله:" قال" ولم يقل: "فقال" كما في قصة نوح لأنه على تقدير سؤال سائل قال: ما قال لهم هود ؟ فقيل: قال يا قوم اعبدوا الله واتقوه.
ومنه حذف همزة الاستفهام، كقوله تعالى: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّي} أي أهذا ربي ؟.
وقوله: {وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} أي أفمن نفسك !.
وقوله: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} أي أو تلك نعمة !.
وقوله: {إِنَّكَ لأَنْتَ يُوسُفُ} على قراءة ابن كثير بكسر الهمزة على خلاف في ذلك جميعه.
ومنه حذف ألف ما الاستفهامية مع حرف الجر للفرق بين الاستفهامية والخبرية، كقوله تعالى: {فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ}{فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا} {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} و{مِمَّ خُلِقَ}.
ومنه حذف الياء في: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} للتخفيف ورعاية الفاصلة.
ومنه حذف حرف النداء،كقوله: {هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ} أي يا هؤلاء.
وقوله: {يُوسُفُ} أي يا يوسف.
وقوله: {رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ} أي يا رب.
ويكثر في المضاف نحو: {فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ} {رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً}.
وكثر ذلك في نداء الرب سبحانه وحكمة ذلك دلالته على التعظيم والتنزيه لأن النداء يتشرب معنى الأمر لأن إذا قلت يا زيد فمعناه أدعوك يا زيد فحذفت يا من نداء الرب ليزول معنى الأمر ويتمحص التعظيم والإجلال.
وقال الصفار: يجوز حذف حرف النداء من المنادى إلا إذا كان المنادى نكرة مقبلا عليها إذ لا دليل عليه وإلا إذا كان اسم إشارة.
ومنه حذف "لو" في قوله تعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} تقديره: لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق.
وقوله: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} معناه لو كان كذلك لارتاب المبطلون.
ومنه حذف "قد" في قوله تعالى: {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ} أي وقد اتبعك لأن الماضي لا يقع موقع الحال إلا و"قد" معه ظاهرة أو مقدرة.
ومثلها: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً} أي وقد كنتم.
وقوله: {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} قيل معناه:" قد حصرت " بدلالة قراءة يعقوب "حصرةً صدورهم". وقال الأخفش: الحال محذوفة، و"حصرت صدورهم" صفتها أي جاءوكم يوما حصرت دعاء عليهم بأن تحصر صدورهم عن قتالهم لقومهم طريقته قاتلهم الله. ورده أبو علي بقوله أي قاتلوا قومهم فلا يجوز أن يدعى عليهم بأن تحصر صدورهم عن قتالهم لقومهم لكن بقول اللهم ألق بأسهم بينهم.
ومنه حذف " أن " في قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً}، المعنى أن يريكم.
وحذف "لا" في قوله: {تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ} أي لا تفتأ لأنها ملازمة للنفي ومعناها لا تبرح.
قوله: {وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ}، أي لا تميد.
وقوله: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بإِثْمِي وَإِثْمِكَ} أي لا تبوء.
وبهذا يزول الإشكال من الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}، أي لا يطيقونه على قول.
فائدة.
[في حذف الجار ثم إيصال الفعل إلى المجرور].
كثر في القرآن حذف الجار ثم إيصال الفعل إلى المجرور به كقوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ} أي من قومه.
{وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ} أي على عقدة.
{إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} ، أي يخوفكم بأوليائه، ولذلك قال: {فَلا تَخَافُوهُمْ}.
{وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً} أي يبغون لها.
{وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاه} أي قدرنا له.
{سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا} أي على سيرتها.
فصل.
[فيما حذف في آية وأثبت في أخرى].
من الأنواع ما حذف في آية وأثبت في أخرى وهو قسمان:.
أحدهما: أن يكون ما حذف منه محمولا على المذكور كالمطلق في الرقبة في كفارة لظهار مقيدا بالمؤمنة في كفارة القتل.
وكقوله: {وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ}، قيدت بالتشبيه في موضع آخر ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ} وقوله في سورة النحل: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ} فإن هذه تقتضي أن الأولى على حذف مضاف.
والقسم الثاني : لا يكون مرادا. فمنه قوله تعالى في سورة المؤمنين: {لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} وفي الزخرف: {لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ}.
وقوله في البقرة: {أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} وفي سورة الأعراف: {أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}.
وحكمته: أنه قد اختلف الخبران في سورة البقرة فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين في الأعراف فإنهما متفقان لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم واحد فكانت الجملة الثالثة مقررة ما في الأولى فهي من العطف بمعزل.
ومنه قوله تعالى في البقرة: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ} وقال في يس: {وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ} مع العاطف وحكمته أن ما في يس وما بعده جملة معطوفة على جملة أخرى فاحتاجت إلى العاطف والجملة هنا ليست معطوفة فهي من العطف بمعزل.
ومنه قوله تعالى: {وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَتَّبِعُوكُمْ} فأثبت الواو في الأعراف وحذفها في الكهف فقال: {وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى} والفرق بينهما أن الذي في الأعراف خطاب لجمع وأصله تدعونهم حذفت للجزم والتي في الكهف خطاب للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو واحد وعلامة الجزم فيه سقوط الواو.
ومنه في آل عمران: {جاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ} وفي فاطر:.
{جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ} والفرق أن الأولى حذفت الباء ففيها للاختصار استغناء بالتي قبلها وخرجت عن الأصل للتوكيد وتقدير المعنى كما تقول مررت بك وبأخيك وبأبيك إذا اختصرت.
ومنه قوله في قصة ثمود: {مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا} وفي قصة شعيب: {وَمَا أَنْتَ} بالواو، والفرق أن الأولى جرى على انقطاع الكلام عند النحويين واستئناف {وَمَا أَنْتَ} فاستغنى عن الواو لما تقرر من الابتداء وفي الثانية جرى في العطف وأن يكون قوله: {وَمَا أَنْتَ} معطوفا على {إِنَّمَا أَنْتَ}.
ومنه قوله تعالى في سورة النحل: {وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} وفي سورة النمل: {وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ} بإثبات النون وحكمته أن القصة لما طالت في سورة النحل ناسب التخفيف بحذف النون بخلافه في سورة النمل فإن الواو استئنافية ولا تعلق لها بما قبلها.
وقوله في البقرة: {فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} وفي آل عمران: {فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} وحكمته أن الخطاب في البقرة لليهود وهم أشد جدالا.
ومنه قوله في الأعراف: {لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا} وفي الأنعام: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا}.
ومنه قوله تعالى في سورة البقرة { ويقتلون النبيين بغير الحق } 1 وفي سورة آل عمران { بغير حق } والحكمة فيه أن الجملة في آل عمران خرجت مخرج الشرط وهو عام فناسب أن يكون النفي بصيغة التنكير حتى يكون عاما وفي سورة البقرة جاء عن أناس معهودين وهو قوله تعالى { ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق } فناسب أن يؤتى بالتعريف لأن الحق الذي كان يستباح به قتل الأنفس عندهم كان معروفا كقوله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } فالحق هنا الذي تقتل به الأنفس معهود معروف بخلاف ما في سورة آل عمران
ومنه قوله تعالى في هود حاكيا عن شعيب { ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون } وأمر نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقول لقريش { ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون }
ويمكن أن يقال لما كررت مراجعته لقوم ناسب اختصاص قصته بالاستئناف الذي هو أبلغ في الإنذار والوعيد وأما نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكانت مدة إنذاره لقومه قصيرة فعقب عملهم على مكافأتهم بوعيدهم بالفاء إشارة إلى قرب نزول الوعيد لهم بخلاف شعيب فإنه طالت مدته في قومه فاستأنف لهم ذكر الوعيد
ولعل قوم شعيب سألوه السؤال المتقدم فأجابهم بهذا الجواب والفاء لا تحسن فيه والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل ذلك جوابا للسؤال ولا يحسن معه الحذف
ومنه أنه تعالى قال في خطاب المؤمنين { هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم }
عَذَابٍ أَلِيمٍ} ، إلى أن قال: {يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ}، وقال في خطاب الكافرين: {يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ}، {يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ}.
قال الزمخشري في تفسير سورة إبراهيم: ما علمته جاء الخطاب هكذا في القرآن إلا في خطاب الكافرين وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين ولئلا يسوي بين الفريقين في الميعاد.
واعترض الإمام فخر الدين بأن هذا التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا الجواب وإن لم يحصل كان هذاالكلام فاسدا.
وقال الشيخ أثير الدين أبو حيان في تفسيره: ويقال: ما فائدة الفرق في الخطاب والمعنى مشترك؟ إذ الكافر إذا آمن والمؤمن إذا تاب مشتركان في الغفران وما تخيلت فيه مغفرة بعض الذنوب منالكافر إذا هو آمن موجود في المؤمن إذا تاب.
وسيأتي بسط الكلام على ذلك في آخر الكتاب.
الإيجاز.
وهو قسم من الحذف ويسمى إيجاز القصر فإن الإيجاز عندهم قسمان وجيز بلفظ ووجيز بحذف.
فالوجيز باللفظ أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقل من القدرالمعهود عادة وسبب حسنه أنه يدل على التمكن في الفصاحة ولهذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أوتيت جوامع الكلم ".و.
اللفظ لا يخلو إما أن يكون مساويا لمعناه وهو المقدر أو أقل منه وهو المقصور.
أما المقدر فكقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} الاية.
وقوله: {قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ} وهو كثير.
وأما المقصور فإما أن يكون نقصان لفظه عن معناه لاحتمال لفظه لمعان كثيرة أولا.
الأول: كاللفظ المشترك الذي له مجازان، أو حقيقة ومجاز إذا أريد معانيه كما في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} فإن الصلاة من الله مغايرة للصلاة من الملائكة والحق أنه من القدر المشترك وهو الاعتناء والتعظيم وكذلك قوله تعالى: { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ} الآية. فإن السجود في الكل يجمعه معنى واحد وهو الانقياد.
والثاني: كقوله: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}.
وقوله: {أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ}.
وكذلك قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} إذ معناه كبير ولفظه يسير.
وقد نظر لقول العرب:" القتل أنفى للقتل "وهو بنون ثم فاء ويروي بتاء ثم قاف ويروي " أوقى " والمعنى أنه إذا أقيم وتحقق حكمة خاف من يريد قتل أحد أن يقتص منه وقد حكاه الحوفي في تفسيره عن علي بن أبي طالب وقال: قول علي في غاية البلاغة وقد أجمع الناس على بلاغته وفصاحته وأبلغ منه قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} وقد تكلموا في وجه الأبلغية. انتهى.
وقد أشار صاحب "المثل السائر" إلى إنكار ذلك وقال: لا نسبة بين كلام الخالق عز وجل وكلام المخلوق وإنما العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك.
وهو كما قال وكيف يقابل المعجز بغيره مفاضلة وهو منه في مرتبة العجز عن إدراكه:
وماذا يقول القائلون إذا بدا جمال خطاب فات فهم الخلائق
وجملة ما ذكروا في ذلك وجوه:.
أحدها: أن قوله: {الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} أوجز فإن حروفه عشرة وحروف "القتل أنفى للقتل" أربعة عشر حرفا والتاء وألف الوصل ساقطان لفظا وكذا التنوين لتمام الكلام المقتضى للوقف.
الثاني: أن قولهم فيه كلفة بتكرير القتل ولا تكرير في الآية.
الثالث : أن لفظ القصاص فيه حروف متلائمة لما فيه من الخروج من القاف إلى الصاد إذ القاف من حروف الاستعلاء والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق،.
بخلاف الخروج من القاف إلى التاء التي هي حرف منخفض فهو غير ملائم وكذا الخروج من الصاد إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى الهمزة لبعد مادون طرف اللسان وأقصى الحلق.
الرابع: في النطق بالصاد والحاء والتاء حسن الصوت ولا كذلك تكرير القاف والفاء.
الخامس: تكرير ذلك في كلمتين متماثلتين بعد فصل طويل وهو ثقل في الحروف أو الكلمات.
السادس: الإثبات أول والنفي ثان عنه والإثبات أشرف.
السابع: أن القصاص المبني على المساواة أوزن في المعادلة من مطلق القتل ولذلك يلزم التخصيص بخلاف الآية.
الثامن: الطباع أقبل للفظ الحياة من كلمة القتل لما فيه من الاختصار وعدم تكرار الكلمة وعدم تنافر الحروف وعدم تكرار الحرفين وقبول الطبع للفظ "الحياة" وصحة الإطلاق.
التاسع : أن نفي القتل لا يستلزم الحياة والآية ناصة على ثبوتها التي هي الغرض المطلوب منه.
العاشر: أن قولهم لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة وقوله في القصاص حياة مفهوم لأول وهلة.
الحادي عشر: أن قولهم خطأ فإن القتل كله ليس نافيا للقتل فإن القتل العدواني لا ينفى القتل وكذا القتل في الردة والزنا لا ينفيه وإنما ينفيه قتل خاص.
وهو قتل القصاص الذي في الآية تنصيص على المقصود والذي في المثل لا يمكن حمله على ظاهره.
الثاني عشر: فيه دلالة على ربط المقادير بالأسباب وإن كانت الأسباب أيضا بالمقادير وكلام العرب يتضمنه إلا أن فيه زيادة وهي الدلالة على ربط الأجل في الحياة بالسبب لا من مجرد نفي القتل.
الثالث عشر: في تنكير "حياة" نوع تعظيم يدل على أن في القصاص حياة متطاولة كقوله: {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ} ولا كذلك المثل فإن اللام فيه للجنس ولهذا فسروا الحياة فيها بالبقاء.
الرابع عشر: فيه بناء أفعل التفضيل من متعد والآية سالمة منه الخامس عشر: أن أفعل في الغالب تقتضي الاشتراك فيكون ترك القصاص نافيا القتل ولكن القصاص أكثر نفيا وليس الأمر كذلك والآية سالمة من هذا.
السادس عشر: أن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق وظهرت فصاحته بخلافه إذا تعقب كل حركة سكون والحركات تنقطع بالسكنات نظيره إذا تحركت الدابة أدنى حركة فخنست ثم تحركت فخنست لا يتبين انطلاقها ولا تتمكن من حركتها على ما تختاره وهي كالمقيدة وقولهم: "القتل أنفي للقتل" حركاته متعاقبة بالسكون بخلاف الآية.
السابع عشر: الآية اشتملت على فن بديع وهو جعل أحد الضدين الذي هو الفناء والموت محلا ومكانا لضده الذي هو الحياة واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة ذكره في الكشاف.
الثامن عشر: أن في الآية طباقا لأن القصاص مشعر بضد الحياة بخلاف المثل.
التاسع عشر: القصاص في الأعضاء والنفوس وقد جعل في الكل حياة فيكون جمعا بين حياةالنفس والأطراف وإن فرض قصاص بما لا حياة فيه كالسن فإن مصلحة الحياة تنقص بذهابه ويصير كنوع آخر وهذه اللطيفة لا يتضمنها المثل.
العشرون: أنها أكثر فائدة لتضمنه القصاص في الأعضاء وأنه نبه على حياة النفس من وجهين من وجه به القصاص صريحا ومن وجه القصاص في الطرف لأن أحد أحوالها أن يسري إلى النفس فيزيلها ولا كذلك المثل.
وقد قيل غير ذلك.
وأما زيادة {لكم} ففيها لطيفة وهي بيان العناية بالمؤمنين على الخصوص وأنهم المراد حياتهم لا غيرهم لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن سواهم.
والحاصل أن هذا من البيان الموجز الذي لا يقترن به شيء.
ومن بديع الإيجاز قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ.} الآية، فإنها نهاية التنزيه.
وقوله: {كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ}، وهذا بينا عجيب يوجب التحذير من الاغترار بالإمهال.
وقوله: {إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ} وقوله: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ} ، وهذا من أحسن الوعد والوعيد.
وقوله: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} فهذه ثلاث كلمات اشتملت على جميع ما في الرسالة.
وقوله: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}، فهذه جمعت مكارم الأخلاق كلها لأن في {خُذِ الْعَفْوَ} صلة القاطعين والصفح عن الظالمين وفي الأمر بالمعروف تقوى الله وصلة الأرحام وصرف اللسان عن الكذب وفي الإعراض عن الجاهلين الصبر والحلم وتنزيه النفس عن مماراة السفيه.
قوله: {مُدْهَامَّتَانِ} معناه مسودتاه من شدة الخضرة.
وقوله: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}.
وقوله: {أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا} فدل بأمرين على ججميع ما أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للأنام من العشب والشجر والحب والتمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح لأن النار من العيدان والملح من الماء.
وقوله: {يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ}، فدل على نفسه ولطفه ووحدانيته وقدرته وهدى للحجة عل من ضل عنه لأنه لو كان ظهور الثمرة بالماء والتربة لوجب في القياس ألا تختلف الطعوم والروائح ولا يقع التفاضل في الجنس الواحد إذا نبت في مغرس واحد ولكنه صنع اللطيف الخبير.
وقوله: {لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ}، كيف نفى بهذين جميع عيوب الخمر وجمع بقوله: {وَلا يُنْزِفُونَ} عدم العقل وذهاب المال ونفاد الشراب.
وقوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لا يُبْصِرُونَ} فدل على فضل السمع والبصر حيث جعل مع الصم فقدان العقل ولم يجعل مع العمي إلا فقدان البصر وحده.
وقوله: {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} كيف أمر ونهى وأخبر ونادى ونعت وسمى وأهلك وأبقى وأسعد وأشقى قص من الأنباء مالو شرح ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام وانحسرت الأيدي.
وقوله تعالى عن النملة: {يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ} فجمع في هذه اللفظة أحد عشر جنسا من الكلام نادت وكنت ونبهت وسمعت وأمرت وقضت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وغدرت فالنداء "يا" والكناية " أيّ " والتنبيه "ها" والتسمية النمل والأمر "ادخلوا" والقصص "مساكنكم" والتحذير "لا يحطمنكم" والتخصيص سليمان والتعميم جنوده والإشارة "وهم" والغدر لا يشعرون. فأدت خمس حقوق حق الله وحق رسوله وحقها وحق رعيتها وحق جنود سليمان فحق الله أنها استرعيت على النمل فقامت بحقهم وحق سليمان أنها نبهته على النمل وحقها إسقاطها حق الله عن الجنود في نصحهم4 وحق الجنود بنصحها لهم ليدخلوا مساكنهم وحق الجنود إعلامها إياهم وجميع الخلق أن من.
استرعاه رعية فوجب عليه حفظها والذب عنها وهو داخل في الخبر المشهور: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ".
ويقال إن سليمان عليه السلام لم يضحك في عمره إلا مرة واحدة وأخرى حين أشرف على وادي النمل فرآها على كبر الثعالب لها خراطيم وأنياب فقال رئيسهم: ادخلوا مساكنكم فخرج كبير النمل في عظم الجواميس فلما نظر إليه سليمان هاله فأراه الخاتم فخضع له ثم قال: أهذه كلها نمل ؟ فقال: إن النمل لكبيرة إنها ثلاثة اصناف: صنف في الجبال وصنف في القرى وصنف في المدن. فقال سلميان عليه السلام: اعرضها علي فقال له: قف. فبقى سليمان عليه السلام تسعين يوما واقفا يمر عليه النمل، فقال: هل انقطعت عساكركم، فقال ملك النمل: لو وقفت إلى يوم القيامة ما انقطعت. فذكر الجنيد أن سليمان عليه السلام قال لعظيم النمل: لم قلت للنمل: ادخلوا مساكنكم ؟ أخفت عليهم من ظلمنا ؟ قال: لا، ولكن خفت أن يفتتنوا بما رأوا من ملكك فيشغلهم ذلك عن طاعة الله.
وقوله: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ}، وهذا أشد ما يكون من الحجاج.
وقوله: {وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ} وهذا أعظم ما يكون من التحسير.
وقوله: {الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ} وهذا أشد ما يكون من التنفير عن الخلة إلا على التقوى.
وقوله: {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ}، وهذا أشد ما يكون من التحذير من التفريط.
وقوله: {أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، وهذا أشد ما يكون من التبعيد.
وقوله: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}، فهذا أعظم ما يكون من التخيير.
وقوله: {وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ} ، وهذا أبلغ ما يكون من التذكير.
وقوله: {كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ}، وهذا أشد ما يكون في التقريع على التمادى في الباطل.
وقوله: {هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ}، وهذا أشد ما يكون من التقريع.
{وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ} وهذا غاية الترهيب.
وقوله: {وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ}، وهذه غاية الترغيب.
وقوله: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ}.
وقوله: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا} وهذا أبلغ ما يكون من الحجاج وهو الأصل الذي عليه أثبتت دلالة التمانع في علم الكلام.
وقوله: {وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} وهذا أبلغ ما يكون من الوصف بكل ما تميل إليه النفس من الشهوات وتلذ الأعين من المرئيات ليعلم أن هذا اللفظ القليل جدا حوى معاني كثيرة لا تنحصر عددا.
وقوله: {يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ} وهذا أشد ما يكون من الخوف.
وقوله: {وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ}.
وقوله: {إِنَّمَا بَغْيُكُمْ}.
وقوله: {وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ}.
وقوله: {هُدىً لِلْمُتَّقِينَ}.
وقوله: {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ}.
وقوله: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} معناه قابلهم بما يفعلونه معك وعاملهم مثل معاملتهم لك سواء مع ما يدل عليه سواء من الأمر بالعدل.
وقوله: {وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ} فإنه أشار به إلى انقطاع مدة الماء النازل.
من السماء والنابع من الأرض وقوله: {وَقُضِيَ الأَمْرُ} أي هلك من قضى هلاكه ونجا من قدرت نجاته وإنما عدل عن لفظه إلى لفظ التمثيل لأمرين اختصار اللفظ وكون الهلاك والنجاة كانا بأمر مطاع إذ الأمر يستدعى آمرا ومطاعا وقضاؤه يدل على قدرته.
ومن أقسام الأيجاز الاقتصار على السبب الظاهر للشيء اكتفاء بذلك عن جميع الأسباب كما يقال فلان لا يخاف الشجعان والمراد لا يخاف أحدا.
ومنه قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} ولا شك أن من فسخت النكاح ايضا تتربص لأن السبب الغالب للفراق الطلاق.
وقوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} ولم يذكر النوم وغيره لأن السبب الضروري النقاض خروج الخارج فإن النوم الناقض ليس بضروري فذكر السبب الظاهر وعلم منه الحكم في الباقي.
ومنه قوله: {يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى} أي وهو مالم يقع في وهم الضمير من الهواجس ولم يخطر على القلوب من مخيلات الوساوس.
ومنه: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} ونظائره.
وكذلك زيد وعمرو قائم على القول بأن قائم خبر عن أحدهما واستغنى به عن خبر الآخر.
ومنها الاقتصار على المبتدأ وإقامة الشيء مقام الخبر نحو أقائم الزيدان فإن قائم مبتدأ لا خبر له.
ومنها باب "علمت أنك قائم" إذا جعلنا الجملة سادة مسد المفعولين فإن الجملة محلة لاسم واحد سد مسد اسمين مفعولين من غير حذف.
ومنه باب النائب عن الفاعل في ضرب زيد ف زيد دل على الفاعل بإعطائه حكمه وعلى المفعول بوضعه.
ومنها جميع أدوات الاستفهام والشرط فإن " كم مالك "؟ يغنى عن عشرين أو ثلاثين ومن يقم أكرمه يغنى عن زيد وعمرو قال ابن الأثير في "الجامع".
ومنه الألفاظ اللازمة للعموم مثل أحد وديار قاله ابن الأثير أيضا.
ومنه لفظ الجمع فإن الزيدين يغنى عن زيد وزيد وزيد وكذا التثنية أصلها رجل ورجل فحذفوا العطف والمعطوف وأقاموا حرف الجمع والتثنية مقامهما اختصارا وصح ذلك لاتفاق الذاتين في التسمية بلفظ واحد فإن اختلف لفظ الاسمين رجعوا إلى التكرار بالعطف نحو مررت بزيد وبكر.
منه باب الضمائر على ما سيأتي بيانه في قاعدة الضمير.
ومنه لفظ "فعل" فإنه يجيء كثيرا كناية عن أفعال متعددة قال تعالى: {لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ}.
{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا} أي فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله.
القول في التقديم والتأخير.
هو أحد أساليب البلاغة فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده لهم وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق.
وقد اختلف في عدة من المجاز فمنهم من عده منه لأنه تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل نقل كل واحد منهما عن رتبته وحقه.
والصحيح أنه ليس منه فإن المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع.
ويقع الكلام فيه في فصول.
الفصل الأول: في أسباب التقديم والتأخير.
الأول: في أسبابه، وهي كثيرة:.
أحدها: أن يكون أصله التقديم ولا مقتضى للعدول عنه كتقديم الفاعل على المفعول والمبتدأ على الخبر وصاحب الحال عليها نحو جاء زيد راكبا.
والثاني: أن يكون في التأخير إخلال ببيان المعنى كقوله تعالى: {وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ} ، فإنه لو أخر قوله: {مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ} فلا يفهم أنه منهم.
وجعل السكاكي من الأسباب كون التأخير مانعا مثل الإخلال بالمقصود،.
كقوله تعالى: {وَقَالَ الْمَلأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} بتقديم الحال أعنى {مِنْ قَوْمِهِ} على الوصف أعنى {الَّذِينَ كَفَرُوا} ولو تأخر لتوهم أنه من صفة الدنيا لأنها هاهنا اسم تفضيل من الدنو وليست أسما والدنو يتعدى بـ"من" وحينئذ يشتبه الأمر في القائلين أنهم أهم من قومه أم لا فقدم لاشتمال التأخير على الإخلال ببيان المعنى المقصود وهو كون القائلين من قومه وحين أمن هذا الإخلال بالتأخير قال تعالى في موضع آخر من هذه السورة: {فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} بتأخير المجرور عن صفة المرفوع.
الثالث: أن يكون في التأخير إخلال بالتناسب فيقدم لمشاكلة الكلام ولرعاية الفاصلة كقوله: {وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} ، بتقديم "إياه" على "تعبدون" لمشاكلة رءوس الآي وكقوله: {فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى} فإنه لو أخر {فِي نَفْسِهِ} عن {مُوسَى} فات تناسب الفواصل لأن قبله: {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} وبعده،: {إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى}.
وكقوله: {وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ} فإن تأخير الفاعل عن المفعول لمناسبته لما بعده.
وكقوله: {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ}، وهو أشكل بما قبله لأن قبله: {مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ}.
وجعل منه السكاكي: {آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى} بتقديم "هارون" مع أن "موسى" أحق بالتقديم.
الرابع: لعظمة والاهتمام به، وذلك أن من عادة العرب الفصحاء إذا أخبرت عن مخبر ما - وأناطت به حكما - وقد يشركه غيره في ذلك الحكم أو فيما أخبر به عنه وقد عطفت أحدهما على الآخر بالواو المقتضية عدم الترتيب - فإنهم مع ذلك إنما يبدءون بالأهم والأولى. قال سيبويه: كأنهم يقدمون الذي شأنه أهم لهم وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم. انتهى.
قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}، فبدأ بالصلاة لأنها أهم.
وقال سبحانه: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}.
وقال تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، فقدم العبادة للاهتمام بها.
ومنه تقدير المحذوف في بسم الله مؤخرا.
وأوردوا: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} ، وأجيب بوجهين:.
أحدهما: أن تقديم الفعل هناك أهم لأنها أول سورة نزلت.
والثاني : أن بأسم ربك متعلق ب أقرأ الثاني ومعنى الأول أوجد القراءة والقصد التعميم.
الخامس : أن يكون الخاطر ملتفتا إليه والهمة معقودة به، وذلك كقوله تعالى:.
{وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ} ، بتقديم المجرور على المفعول الأول لأن الإنكار متوجه إلى الجعل لله لا إلى مطلق الجعل.
السادس: أن يكون التقديم لإرادة التبكيت والتعجيب من حال المذكور كتقديم المفعول الثاني على الأول في قوله تعالى: { وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ}، والأصل" الجن شركاء "، وقدم لأن المقصود التوبيخ وتقديم الشركاء أبلغ في حصوله.
ومنه قوله تعالى في سورة يس: {وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى} وسنذكره.
السابع: الاختصاص، وذلك بتقديم المفعول والخبر والظرف والجار والمجرور ونحوها على الفعل كقوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}، أي نخصك بالعبادة فلا نعبد غيرك.
وقوله: {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} أي إن كنتم تخصونه بالعبادة.
والخبر كقوله: {قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي}، وقوله: {وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ}.
وأما تقديم الظرف، ففيه تفصيل فإن كان في الإثبات دل على الاختصاص كقوله تعالى :{إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ}، وكذلك: {لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ} ، فإن ذلك يفيد اختصاص ذلك بالله تعالى: وقوله: {لإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ}.
أي لا إلى غيره وقوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} أخرت صلة الشهادة في الأول وقدمت في الثاني لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الأمم وفي اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم.
وقوله: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} أي لجميع الناس من العجم والعرب على أن التعريف للاستغراق.
وإن كان في النفي فإن تقديمه يفيد تفضيل المنفى عنه كما في قوله تعالى: {لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ}، أي ليس في خمر الجنة ما في خمرة غيرها من الغول وأما تأخيره فإنها تفيد النفي فقط كما في قوله: {لا رَيْبَ فِيهِ} فكذلك إذا قلنا لاعيب في الدار كان معناه نفي العيب في الدار وإذا قلنا لا في الدار عيب كان معناه أنها تفضل على غيرها بعدم العيب.
تنبيه:.
ما ذكرناه من أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص فهمه الشيخ أبو حيان في كلام الزمخشري وغيره، والذي عليه محققو البيانيين أن ذلك غالب لا لازم، بدليل قوله تعالى: {كلاًًّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ} وقوله: {أَفِي اللَّهِ شَكٌّ} إن جعلنا ما بعد الظرف مبتدأ.
وقد رد صاحب "الفلك الدائر" القاعدة بالآية الأولى وكذلك ابن الحاجب والشيخ أبو حيان وخالفوا البيانيين في ذلك وأنت إذا علمت أنهم.
ذكروا في ذلك قيد الغلبة سهل الأمر. نعم له شرطان:.
أحدهما: ألا يكون المعمول مقدما بالوضع فإن ذلك لا يسمى تقديما حقيقة كأسم الاستفهام وكالمبتدأ عند من يجعله معمولا لخبره.
والثاني: ألا يكون التقديم لمصلحة التركيب مثل: {وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ} على قراءة النصب.
وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة وهي قوله: {أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ} ، التقديم في الأول قطعا ليس للاختصاص بخلاف الثاني.
الفصل الثاني: في أنواعه.
وهي إما أن يقدم والمعنى عليه أو يقدم وهو في المعنى مؤخر أو بالعكس.
النوع الأول: ما قدم والمعنى عليه.
ومقتضياته كثيرة قد يسر الله منها خمسا وعشرين ولله در ابن عبدون في قوله:
سقاك الحيا من معان سفاح فكم لي بها من معان فصاح
أحدها: السبق.
وهو أقسام: منها السبق بالزمان والإيجاد، كقوله تعالى: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ} قال ابن عطية: المراد بالذين اتبعوه في زمن الفترة.
وقوله: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ} فإن مذهب أهل السنة تفضيل البشر وإنما قدم الملك لسبقه في الوجود.
وقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ} فإن الأزواج أسبق بالزمان لأن البنات أفضل منهن لكونهن بضعة منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقوله: {هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ}.
واعلم أنه ينضم إليه مع ذلك التشريف كقوله :{إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ}.
وقوله: {وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى}.
{صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى}.
وأما قوله: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} فإنما قدم ذكر موسى لوجهين: أحدهما : أنه في سياق الاحتجاج عليهم بالترك وكانت صحف موسى منتشرة أكثر انتشارا من صحف إبراهيم. وثانيهما: مراعاة رءوس الآى.
وقد ينضم إليه التحقير، كما في قوله: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}، تقدم اليهود لأنهم كانوا أسبق من النصارى ولأنهم كانوا أقرب إلى المؤمنين بالمجاورة.
وقد لا يلحظ هذا كقوله تعالى: {وَعَاداً وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ} وقوله: {وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى}.
ومن التقديم بالإيجاد تقديم السنة على النوم في قوله: {تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ} لأن العادة في البشر أن تأخذ العبد السنة قبل النوم فجاءت العبارة على حسب هذه العادة.
ذكره السهيلي وذكر معه وجها آخر، وهو أنها وردت في معرض التمدح والثناء وافتقاد السنة أبلغ في التنزيه فبدىء بالأفضل لأنه إذا استحالت عليه السنة فأحرى أن يستحيل عليه النوم.
ومنه تقديم الظلمة على النور في قوله تعالى: {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} فإن الظلمات سابقة على النور في الإحساس وكذلك الظلمة المعنوية سابقة على النور المعنوي قال تعالى: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ} فانتفاء العلم ظلمة وهو متقدم بالزمان على نور الإدراكات.
ومنه تقديم الليل على النهار: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ} {سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ} {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} {حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ.
تُصْبِحُونَ} ولذلك اختارت العرب التاريخ بالليالي دون الأيام وإن كانت الليالي مؤنثة والأيام مذكرة وقاعدتهم تغليب المذكر إلا في التاريخ.
فإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى: {لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ}.
قلت: استشكل الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في قواعده بالإجماع على سبق الليلة على اليوم وأجاب بأن المعنى: تدرك القمر في سلطانه وهو الليل أي لا تجيء الشمس في أثناء الليل فقوله بعده: {وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} أي لا يأتي في بعض سلطان الشمس وهو النهار وبين الجملتين مقابلة.
فإن قيل: قوله تعالى: {يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ} مشكل على هذا لأن الإيلاج إدخال الشيء في وهذا البحث ينافيه.
قلت: المشهور في معنى الآية أن الله يزيد في زمن الشتاء مقدارا من النهار ومن النهار في الصيف مقدارا من الليل وتقدير الكلام: يولج بعض مقدار الليل في النهار وبعض مقدار النهار في الليل وعلى غير المشهور يجعل الليل في المكان الذي كان فيه النهار ويجعل النهار في المكان الذي كان فيه الليل والتقدير: يولج الليل في مكان النهار ويولج النهار في مكان الليل.
ومنه تقديم المكان على الزمان في قوله: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ.
وَالنُّورَ} أي الليل والنهار، وقوله: {وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وََهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}.
وهذه مسألة مهمة قل من تعرض لها أعنى سبق المكان على الزمان وقد صرح بها الإمام أبو جعفر الطبري في أول تاريخه واحتج على ذلك بحديث ابن عباس: إن الله خلق التربة يوم السبت وخلق الشمس والقمر وكان ذلك كله ولا ليل ولا نهار إذ كانا إنما هما أسماء لساعات معلومة من قطع الشمس والقمر "درج الفلك" وإذا كان ذلك صحيحا وأنه لا شمس ولا قمر كان معلوما أنه لا ليل ولا نهار قال: وحديث أبي هريرة - يعني في صحيح مسلم - صريح فيه فإن فيه: " وخلق [الله] النور يوم الأربعاء " قال: ويعني به الشمس إن شاء الله.
والحاصل أن تأخر خلق الأيام عن بعض الأشياء المذكورة في الخبر لازم.
فإن قلت: الحديث كالمصرح بخلافه فإنه قال خلق الله التربة يوم السبت حين خلق البرية وهي أول المخلوقات المذكورة فلا يمكن أن يكون خلق الأيام كلها متأخرا عن ذلك.
قلت: قد نبه الطبري على جواب ذلك بما حاصله أن الله تعالى سمى أسماء الأيام قبل خلق التربة وخلق الأيام كلها ثم قدر كل يوم مقدارا فخلق التربة في مقدار يوم السبت قبل خلقه يوم السبت وكذا الباقي.
وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكن أوجبه ما قاله الطبري من أنه يتعين تأخير الأيام لما ذكرناه من الدليل المستفاد من الخبرين.
والحاصل أن الزمان قسمان تحقيقي وتقديري والمذكور في الحديث التقديري.
ومنه قوله تعالى: {رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ}، {مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا}، ولذلك لما استغنى عن أحدهما ذكر المشرق فقد فقال: {وَرَبُّ الْمَشَارِقِ} {إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا}.
ومنه قوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ} وقوله: {وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا} {وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ}.
ويمكن فيه وجوه آخر:.
منها: أن فيه قهرا للخلق والمقام يقتضيه.
ومنها: أن حياة الإنسان كلاحياة ومآله إلى الموت ولا حياة إلا بعد الموت.
ومنها: أن الموت تقدم في الوجود إذ الإنسان قبل نفخ الروح فيه كان ميتا لعدم الروح.
وهذا إن أريد بالموت عدم الوجود بدليل {وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ} وإن أريد به بعد الوجود فالناس منتازعون في الموت هل هو أمر وجودي كالحياة أولا ؟.
وقيل بالوقف، فقالت الفلاسفة: الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا.
والجمهور على أنه أمر وجودي يضاد الحياة محتجين بقوله: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ} والحديث في الإتيان بالموت في صورة كبش وذبحه.
وأجيب عن الآية بأن الخلق بمعنى التقدير، ولا يجب في المقدر أن يكون وجوديا وعن الثاني بأن ذلك على طريق التمثيل لبيان انقطاع الموت وثبوت الخلود.
فإن قلنا: عدمي، فالتقابل بينه وبين الحياة تقابل العدم والملكة وعلى الصحيح تقابل التضاد وعلى القول بأنه وجودي يجب أن يقال تقديم الموت الذي هو عدم الوجود،.
لكونه سابقا أو معدوم الحياة الذي هو مفارقة الروح البدني يجوز أن يكون لكونه الغاية التي يساق إليها في دار الدنيا فهي العلة الغائبة بعدم تحقيقها لتحقق فخص العلة العامة كما وقع تأكيده في قوله: {ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ} أو تزهيدا في الدار الفانية وترغيبا فيما بعد الموت.
فإن قيل: فما وجه تقدم "الحياة" في قوله: {فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ} وقوله: {وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ؟.
قلنا: إن كان الخطاب لآدم وحواء فلأن حياتهما في الدنيا سبقت الموت وإن كان للخلق بالخطاب لمن هو حي يعقبه الموت فما التقديم بالترتيب وكذا الآية بعده.
فإن قيل: فما وجه تقديم الموت على الحياة في الحكاية عن منكر البعث: {إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا} ؟.
قلت: لأجل مناسبة رءوس الآي.
فإن قلت: فما وجه تقدم التوفي على الرفع في قوله: {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} مع أن الرفع سابق ؟.
قيل: فيه جوابان:.
أحدهما: المراد بالتوفي النوم، كقوله تعالى: { يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ}.
وثانيهما: أن التاء في "متوفيك" زائدة أي موفيك عملك.
ومنها سبق إنزال، كقوله: {وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْأِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ} . وقوله: {الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ}.
وأما قوله: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ} فإنما قدم القرآن منبها له على فضيلة المنزل إليهم.
ومنها سبق وجوب كقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} وقوله: {تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً}.
فإن قيل فقد قال: {وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ}.
قيل: يحتمل أنه كان في شريعتهم السجود قبل الركوع ويحتمل أن يراد بالركوع ركوع الركعة الثانية.
وقيل: المراد بـ"اركعي" اشكري.
وقيل: أراد بـ"اسجدي" صلي وحدك. وبـ"اركعي" صلي في جماعة، ولذلك قال: {مَعَ الرَّاكِعِينَ}.
ومنها سبق تنزيه، كقوله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ} فبدأ بالرسول قبل المؤمنين، ثم قال: {كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ} فبدأ بالإيمان بالله لأنه قد يحصل بدليل العقل والعقل سابق في الوجود على الشرع ثم قال:" وملائكته " مراعاة لإيمان الرسول فإنه يتعلق بالملك الذي هو جبريل أولا ثم بالكتاب الذي نزل به جبريل ثم بمعرفة نفسه أنه رسول. وإنما عرف نبوة نفسه بعد معرفته بجبريل عليه السلام وإيمانه فترتب الذكر المنزل عليه بحسب ذلك فظهرت الحكمة والإعجاز فقال: {كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} لأن الملك هو النازل بالكتاب وإن كان الكتاب أقدم من الملك ولكن رؤية النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للملك كانت قبل سماعه الكتاب وأما إيماننا نحن بالعقل آمنا بالله أي.
بوجوده ولكن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عرفنا اسمه وجوب النظر المؤدي إلى معرفته فآمنا بالرسول ثم بالكتاب المنزل عليه وبالملك النازل به فلو ترتب اللفظ على حسب إيماننا لبدأ بالرسول قبل الكتاب ولكن إنما ترتب على حسب إيمان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الذي هو إمام المؤمنين. ذكره السهيلي في آماليه.
وقال غيره: في هذا الترتيب سر لطيف وذلك لأن النور والكمال والرحمة والخير كله مضاف إلى الله تعالى والوسائط في ذلك الملائكة والمقابل لتلك الرحمة هم الأنبياء والرسل فلا بد أولا من أصل وثانيا من وسائط وثالثا من حصول تلك الرحمة ورابعا من وصولها إلى المقابل لها والأصل المقتضى للخيرات والرحمة هو الله ومن أعظم رحمة رحم بها عباده إنزال كتبه إليهم والموصل لها هم الملائكة والمقابل لها المنزلة عليهم هم الأنبياء فجاء الترتيب على ذلك بحسب الوقائع.
الثاني: بالذات.
كقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}. ونحوه {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ} وقوله: {سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ} وكذلك جميع الأعداد كل مرتبة هي متقدمة على ما فوقها بالذات.
وأما قوله تعالى: {إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ} فوجه تقديم المثنى أن المعنى حثهم على القيام بالنصيحة لله وترك الهوى مجتمعين متساويين أو منفردين متفكرين ولا شك أن الأهم حالة الاجتماع فبدأ بها.
الثالث: بالعلة والسببية.
كتقديم "العزيز" على "الحكيم" لأنه عز فحكم وتقديم "العليم" على "الحكيم" لأن الإتقان ناشىء عن العلم وكذا أكثر ما في القرآن من تقديم وصف العلم على الحكمة: {قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}.
ويجوز أن يكون قدم وصف العلم هنا ليتصل بما يناسبه وهو {لا عِلْمَ لَنَا} وفي غيره من نظائره لأنه صفات ذات فيكون من القسم قبله.
ومنه قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } قدمت العبادة لأنها سبب حصول الإعانة.
وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} فإن التوبة سبب الطهارة.
وكذا: {وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ} لأن الإفك سبب الإثم.
وكذا: {وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ}.
وقوله: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً} قدم إحياء الأرض لأنه سبب إحياء الأنعام والأناسي وقدم إحياء الأنعام لأنه مما يحيا به الناس بأكل لحومها وشرب ألبانها.
وكذا كل علة مع معلولها كقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ}، قيل: قدم الأموال من باب تقديم السبب فإنه إنما شرع النكاح عند قدرته على مؤونته فهو سبب والتزويج سبب للتناسل ولأن المال سبب للتنعيم بالولد وفقده سبب لشقائه.
وكذا تقديم البنات على البنين في قوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ} وأخر ذكر الذهب والفضة عن النساء والبنين لأنهما أقوى في الشهوة الجبلية من المال فإن الطبع يحث على بذل المال فيحصل النكاح والنساء أقعد من الأولاد في الشهوة الجبلية والبنون أقعد من الأموال والذهب أقعد من الفضة والفضة أقعد من الأنعام إذ هي وسيلة إلى تحصيل النعم فلما صدرت الآية بذكر الحب وكان المحبوب مختلف المراتب اقتضت حكمة الترتيب أن يقدم ما هو الأهم فالأهم في رتبة المحبوبات.
وقال الزمخشري في قوله تعالى: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ} قدم الشكر على الإيمان لأن العاقل ينظر "إلى" ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه وتعريضة للمنافع فيشكر شكرا مبهما فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم آمن به ثم شكر شكرا متصلا فكان الشكر متقدما على الإيمان وكأنه أصل التكليف ومداره. انتهى.
وجعله غيره من عطف الخاص على العام لأن الإيمان من الشكر وخص بالذكر لشرفه.
الرابع: بالرتبة.
كتقديم "سميع" على "عليم" فإنه يقتضى التخويف والتهديد فبدأ بالسميع لتعلقه بالأصوات وإن من سمع حسك فقد يكون أقرب إليك في العادة ممن يعلم وإن كان علم الله تعلق بما ظهر وما بطن.
وكقوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} فإن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة وإنما تأخرت في آية سبأ في قوله: {الرَّحِيمُ الْغَفُورُ} لأنها منتظمة في سلك تعداد أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم وهو قوله: {مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ} فالرحمة شملتهم جميعا والمغفرة تخص بعضا والعموم قبل الخصوص بالرتبة.
وقوله تعالى: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} فإن الهماز هو المغتاب وذلك لا يفتقر إلى شيء بخلاف النميمة.
وقوله: {يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} فإن الغالب أن الذين يأتون رجالا من مكان قريب والذين يأتون على الضامر من البعيد. ويحتمل أن يكون من التقديم بالشرف لأن الأجر في المشي مضاعف.
وأما قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} مع أن الراكب متمكن من الصلاة أكثر من الماشي فجبرا له في باب الرخصة.
ومنه قوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} فقدم الطائفين لقربهم من البيت ثم ثنى بالقائمين وهم العاكفون لأنهم يخصون موضعا بالعكوف والطواف بخلافه فكان أعم منه والأعم قبل الأخص ثم ثلث بالركوع لأن الركوع لا يلزم أن يكون في البيت ولا عنده.
ثم في هذه الآية ثلاثة أسئلة:.
الأول: كيف جمع الطائفين والقائمين جمع سلامة والركع جمع تكسير ؟ والجواب: أن جمع السلامة أقرب إلى لفظ الفعل فطائفون بمنزلة يطوفون ففي لفظة إشعار بصلة التطهير وهو حدوث الطواف وتجدده ولو قال: بالطواف لم يفد ذلك لأن لفظ المصدر يخفي ذلك وكذا القول في القائمين وأما الراكعون فلما سبق أنه لا يلزم كونه في البيت ولا عنده فلهذا لم يجمع جمع سلامة إذ لا يحتاج فيه إلى بيان الفعل الباعث على التطهير كما احتيج فيما قبله.
الثاني: كيف وصف الركع بالسجود ولم يعطف بالواو ؟.
والجواب: لأن الركع هم السجود والشيء لا يعطف على نفسه لأن السجود يكون عبارة عن المصدر وهو هنا عبارة عن الجمع فلو عطف بالواو لأوهم إرادة المصدر دون اسم الفاعل لأن الراكع إن لم يسجد فليس براكع شرعا ولو عطف بالواو لأوهم أنه مستقل كالذي قبله.
الثالث: هلا قيل السجد كما قيل الركع وكما جاء في آية أخرى: {تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً} والركوع قبل السجود! والجواب: أن السجود يطلق على وضع الجبهة بالأرض وعلى الخشوع فلو قال: المسجد لم يتناول إلا المعنى الظاهر ومنه: {تَرَاهُمْ.
رُكَّعاً سُجَّداً} وهو من رؤية العين ورؤية العين لا تتعلق إلا بالظاهر فقصد بذلك الرمز إلى السجود المعنوي والصوري بخلاف الركوع فإنه ظاهر في أعمال الظاهر التي يشترط فيها البيت كما في الطواف والقيام المتقدم دون أعمال القلب فجعل السجود وصفا للركوع وتتميما له لأن الخشوع روح الصلاة وسرها الذي شرعت له.
الخامس: بالداعية.
كتقدم الأمر بغض الأبصار على حفظ الفروج في قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} لأن البصر داعية إلى الفرج لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " العينان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ".
السادس: التعظيم.
كقوله: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ}.
وقوله: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}.
{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ}.
{إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا}.
السابع: الشرف وهو أنواع.
منها: شرف الرسالة، كقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ} فإن الرسول أفضل من النبي خلافا لابن عبد السلام.
وقوله: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ} {وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً}.
ومنها: شرف الذكورة:.
كقوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ}.
وقوله: {أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنْثَى}.
وقوله: {رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً}.
وأما تقديم الإناث في قول تعالى: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً} فلجبرهن إذ هن موضع الانكسار ولهذا جبر الذكور بالتعريف للإشارة إلى ما فاتهم من فضيلة التقديم.
ويحتمل أن تقديم الإناث لأن المقصود بيان أن الخلق كله بمشيئة الله تعالى لا على وفق غرض العباد.
ومنها: شرف الحرية، كقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} ومن الغريب حكاية بعضهم قولين في أن الحر أشرف من العبد أم لا حكاه القرطبي في تفسير سورة النساء فلينظر فيه.
ومنها: شرف العقل، كقوله تعالى: {يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ}.
وقوله: {مَتَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ}.
وأما تقديم الأنعام عليهم في قوله: {تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ} فمن باب تقديم السبب وقد سبق.
ومنها: شرف الإيمان، كقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا} وكذلك تقديم المسلمين على الكافرين في كل موضع والطائع على العاصي وأصحاب اليمين عن أصحاب الشمال.
ومنها: شرف العلم، كقوله تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ}.
ومنها: شرف الحياة، كقوله تعالى: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ}.
وقوله: {وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ}. وأما تقديم الموت في قوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ} فمن تقدم السبق بالوجود وقد سبق.
ومنها: شرف المعلوم، نحو: {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ} فإن علم الغيبيات أشرف من المشاهدات.
ومنه: {يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ}.{وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ}.
وأما قوله: {فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى} ، أي من السر فعن ابن عباس وغيره: " السر: ما أسررت في نفسك وأخفى منه ما لم تحدث به نفسك مما يكون في عد علم الله فيهما سواء " ولا شك أن الآتي أبلغ وفيه وجهان:.
أحدهما: أنه أفعل تفضيل يستدعي مفضلا عليه علم حتى يتحقق في نفسه فيكون حينئذ تقديم السر من النوع الأول.
وثانيهما: مراعاة رءوس الآي.
ومنها شرف الإدراك، كتقديم السمع على البصر والسميع على البصير لأن السمع أشرف على أرجح القولين عند جماعة وقدم القلب عليهما في قوله تعالى: {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ} لأن الحواس خدمة القلب وموصلة إليه وهو المقصود وأما قوله: {وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ} فأخر القلب فيها لأن العناية هناك بذم المتصامين عن السماع ومنهم الذين كانوا يجعلون القطن في آذانهم حتى لا يسمعوا ولهذا صدرت السورة بذكرهم في قوله: {وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا}.
ومنها: شرف المجازاة، كقوله: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ}.
ومنها: شرف العموم، فإن العام أشرف من الخاص كتقديم العفو على الغفور أي عفو عما لم يؤاخذنا به مما نستحقه بذنوبنا غفور لما واخذنا به في الدنيا قبلنا ورجعنا إليه فتقدم العفو على الغفور لأنه أعم وأخرت المغفرة لأنها أخص.
ومنها: شرف الإباحة للإذن بها، كقوله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ}، وإنما تقديم الحرام في قوله: {فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً} فللزيادة في التشنيع عليهم أو لأجل السياق لأن قبله: {فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً}. ثم {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ}.
ومنها: الشرف بالفضيلة، كقوله تعالى: {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ} وقوله: {وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ} وقوله: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} الآية. وقوله: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ}{ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ} وقوله: {رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ} في الأعراف والشعراء فإن موسى استأثر باصطفائه تعالى له بتكليمه وكونه من أولى العزم فإن قلت فقد جاء هارون وموسى في سورة طه بتقديم هارون قلنا لتناسب رءوس الآي ومنه تقديم جبريل على ميكائيل في قوله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} لأن جبريل صاحب الوحي والعلم وميكائيل.
صاحب الأرزاق والخيرات النفسانية أفضل من الخيرات الجسمانية.
ومنه تقديم المهاجرين، في قوله تعالى: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَار}.
وقوله: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ} ويدل على فضيلة الهجرة قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لولا الهجرة لكنت أمرأ من الأنصار" وبالآية احتج الصديق على تفضيلهم وتعيين الإمامة فيهم.
ومنه قوله: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} فإن الصلاة أفضل من السلام وقوله: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ} قدم القريب لأن الصدقة عليه أفضل من الأجنبي.
ومنه تقديم الوجه، في قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ}.
وتقديم اليمين على الشمال، في نحو: {جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ} {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ}.
ومنه تقديم الأنفس على الأموال، في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ}. وأما تقديم الأموال في سورة الأنفال في قوله: {وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} فوجه التقديم أن الجهاد يستدعي تقديم إنفاق الأمولا فهو من باب السبق بالسببية.
ومنه :{مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} فإن الحلق أفضل من التقصير.
ومنه تقديم السموات على الأرض، كقوله: {خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ} وهو كثير وكذلك كثير ما يقع السموات بلفظ الجمع والأرض لم تقع إلا مفردة.
وأما تأخيرها عنها في قوله: {وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ} فلأنه لما ذكر المخاطبين، وهو قوله: {وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ} وهو خطاب لأهل الأرض وعملهم يكون في الأرض وهذا بخلاف الآية التي في سبأ فإنها منتظمة في سياق علم الغيب.
وكذلك قوله: {إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ}.
وأما تأخيرها عنها في قوله: {وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} فلأن الآية في سياق الوعد والوعيد وإنما هو لأهل الأرض.
وكذا قوله: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ}.
ومنه تقديم الإنس على الجن في قوله: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ} الاية.
وقوله: {فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ} وقوله: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ} وقوله: {وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً}.
وقوله: {خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ}.
وأما تقديم الجن في مواضع أخر كقوله: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ} فلأنهم أقدم في الخلق فيكون من النوع الأول - أعنى التقديم بالزمان - ولهذا لما أخر في آية الحجر صرح بالقبلية بذكر الإنسان ثم قال: {وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ}.
ويجوز أن يكون في الأمثلة السالفة من باب تقديم الأعجب لأن خلقها أغرب كقوله تعالى: {فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ}.
أو لأنهم أقوى أجساما وأعظم أقداما ولهذا قدموا في: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} وفي: {وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالطَّيْرِ}.
ومنه تقديم السجد على الراكعين في قوله: {وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} وسبق فيه شيء آخر.
ومنه تقديم الخيل على البغال والبغال على الحمير في قوله تعالى :{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا}.
ومنه تقديم الذهب على الفضة في قوله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}.
فإن قلت: فهل يجوز أن يكون من تقديم المذكر على المؤنث ؟.
قلت: هيهات الذهب أيضا مؤنت ولهذا يصغر على ذهيبة كـ"قدم".
ومنه تقديم الصوف في قوله: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا} ولهذا احتج به بعض الصوفية على اختيار لبس الصوف على غيره من الملابس وأنه شعار الملائكة في قوله: { مُسَوِّمِينَ} قيل: سيماهم يؤمئذ الصوف. وعن علي: الصوف الأبيض رواه أبو نعيم في مدح الصوف وقال: إنه شعار الأنبياء. وقال ابن مسعود: " كانت الأنبياء قبلكم يلبسون الصوف " وفي الصحيح في موسى عليه السلام: " عليه عباءة ".
منه تقديم الشمس على القمر في قوله تعالى: {وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} وقوله: {وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُنِيراً} ولهذا قال تعالى: {جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً}، والحكماء يقولون: إن نور القمر مستمد من نور الشمس، قال الشاعر:
يا مفردا بالحسن والشكل من دل عينيك على قتلي
البدر من شمس الضحى نوره والشمس من نورك تستملي
وأما قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً} فيحتمل وجهين مناسبة رءوس الآي أو أن انتفاع أهل السموات به أكثر قال ابن الأنباري يقال إن القمر وجهه يضيء لأهل الشمس.
وظهره إلى الأرض ولهذا قال تعالى: {فِيهِنَّ} لما كان أكثر نوره يضيء إلى أهل السماء.
الثامن: الغلبة والكثرة.
كقوله تعالى: {مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ} قدم الظالم لكثرته ثم المقتصد ثم السابق.
وقوله: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ}{مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ}.
{الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ}.
وجعل منه الزمخشري: {فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ} يعني بدليل قوله: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} وحديث بعث النار.
وأما قوله: {فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً} قدم ذكر العذاب لكون الكلام مع اليهود الذين كفروا بعيسى وراموا قتله.
وجعل من هذا النوع قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} لأن السرقة في الذكور أكثر.
وقدم في الزنى المرأة في قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} لأن الزنى فيهن أكثر وأما قوله:.
{الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}.
فقال الزمخشري: سيقت الآية التي قبلها لعقوبتهما على ما جنيا والمرأة هي المادة التي نشأت منها الخيانة لأنها لو لم تطمع الرجل [ولم تومض له] وتمكنه لم يطمع ولم يتمكن فلما كانت أصلا وأولا في ذلك بدأ بذكرها وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل [فيه] لأنه هو الراغب والخاطب يبدأ الطلب.
ومنه قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}، قال الزمخشري: قدم غض البصر لأن النظر يريد الزنى ورائد الفجور والبلوى به أشد وأكثر ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه.
ومنه تقديم الرحمة على العذاب، حيث وقع في القرآن ولهذا ورد: " إن رحمتي غلبت غضبي ".
وأما تقديم التعذيب على المغفرة في آية المائدة فللسياق.
ومنه قوله تعالى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ} قال ابن الحاجب في أماليه: إنما قدم الأزواج لأن المقصود الإخبار أن فيهم أعداء ووقوع ذلك في الأزواج أقعد منه في الأولاد فكان أقعد في المعنى المراد فقدم ولذلك قدمت الأموال في قوله: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ} لأن الأموال لا تكاد تفارقها الفتنة: {إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى}{مَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا} ، وليست الأولاد في استلزام الفتنة مثلها وكان تقدمها أولى.
التاسع: سبق ما يقتضى تقديمه.
وهو دلالة السياق كقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ} لما كان إسراحها وهي خماص وإراحتها وهي بطان قدم الإراحة لأن الجمال بها حينئذ أفخر.
وقوله: {وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ} لأن السياق في ذكر مريم في قوله: {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} ولذلك قدم الابن في غير هذا المكان قال تعالى: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً} وقوله: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} فإنه قدم الحكم مع أن العلم لا بد من سبقه للحكم ولكن لما كان السياق في الحكم قدمه قال تعالى: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} ، ويحتمل أن المراد بالحكم الحكمة وبها فسر الزمخشري قوله تعالى في سورة يوسف: {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً} وأما تقديم الحكيم على العليم في سورة الانعامفلأنه مقام تشريع الأحكام وأما في أول سورة يوسف فقدم العليم على الحكيم لقوله في آخرها: {وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ}.
ومنه تقديم المحو على الإثبات في قوله: {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} فإن قبله: {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} ويمكن أن يقال ما يقع عليه المحو أقل مما يقع عليه غيره ولا سيما على قراءة تشديد يثبت فإنها ناصة على الكثرة والمراد به الاستمرار لا الاستئناف.
وقوله: {وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ}.
ومنه قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً}، قدم "رسلا" هنا على "من قبلك" وفي غير هذه بالعكس لأن السياق هنا في الرسل.
ومنه قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ} قدم القبض لأن قبله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة وكان هذا بسطا فلا يناسب تلاوة البسط فقدم القبض لهذا وللترغيب في الإنفاق لأن الممتنع منه سببه خوف القلة فبين أن هذا لا ينجيه فإن القبض مقدر ولا بد.
العاشر: مراعاة اشتقاق اللفظ.
كقوله: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ}.
{عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ}.
{يُنَبَّأُ الإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ}.
{قُلْ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ}.
{ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ}.
{وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ}.
وأما قوله: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ } فقدم نفي التأخير لأنه الأصل في الكلام وإنما ذكر التقدم مع عدم إمكان التقدم نفيا لأطراف الكلام كله.
وكقوله: {إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ}.
وقوله: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ}.
{لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ}.
{لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ}.
وقوله: {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ}.
{فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ}.
فإن قلت قد جاء: {فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَى}.{أَمْ لِلإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالأُولَى}.
قلت: لمناسبة رءوس الآى.
ومثله: {هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالأَوَّلِينَ} ولأن الخطاب لهم فقدموا.
الحادي عشر: للحث عليه خيفة من التهاون به.
كتقديم تنفيذ الوصية على وفاء الدين في قوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فإن وفاء الدين سابق على الوصية لكن قدم الوصية لأنهم كانوا يتساهلون بتأخيرها بخلاف الدين.
ونظيره: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً} قدم الإناث حثا على الإحسان إليهم.
وقال السهيلي في [النتائج]: إنما قدمت الوصية لوجهين:.
أحدهما: أنها قربة إلى الله تعالى بخلاف الدين الذي تعوذ الرسل منه فبدىء بها للفضل.
والثاني: أن الوصية للميت والدين لغيره ونفسك قبل نفس غيرك تقول هذا لي وهذا لغيري ولا تقول في فصيح الكلام هذا لغيري وهذا لي.
الثاني عشر: لتحقق ما بعده واستغنائه هو عنه في تصوره .
كقوله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}.
وقوله: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً}.
وقوله: {وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تَابُوا}.
الثالث عشر: الاهتمام عند المخاطب.
كقوله: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}.
ونظيره قوله عليه السلام: " وأن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرفه ".
وقوله: {وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} لفضل الصدقة على القريب.
وكقوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.
وقوله: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} فقدم الكفارة على الدية وعكس في قتل المعاهد حيث قال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.
قال الماوردي في [الحاوي]: ووجهه أن المسلم يرى تقديم حق الله على نفسه والكافر يرى تقديم نفسه على حق الله قال: وقال ابن أبي هريرة: " إنما خالف بينهما ولم يجعلهما على نسق واحد لئلا يلحق بهما ما بينهما من قتل المؤمن في دار الحرب في قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} فضم إليه الدية إلحاقا بأحد الطرفين "، فأزال هذا الاحتمال باختلاف اللفظين.
وقال الفقيه نجم الدين بن الرفعة: يحتمل أن يقال إنه لما كان الكفر يهدر الدماء وهو موجود كان الغاية ببذل الدم عند العصمة لأجل الميثاق أتم لأنه يغمض حكمته فلذلك قدمت الدية فيه وأخرت الكفارة لأن حكمها قد سبق. ولما كانت عصمة المسلم ثابتة وقياس الأصول أنه لا تجب الكفارة في قتل الخطأ لأنه لا إثم فيه خصوصا على المسلمين لرفع القلم عن الخطأ كانت العناية بذكر الكفارة فيه أتم لأنها التي تغمض فقدمت.
ومن هذا النوع قوله تعالى: {فَأَتْبَعَ سَبَباً حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ} قيل: لماذا بدأ بالمغرب قبل المشرق وكان مسكن ذي القرنين من ناحية المشرق ؟ قيل: لقصد الاهتمام إما لتمرد أهله وكثرة طغيانهم في ذلك الوقت أو غير ذلك مما لم ينته إلينا علمه.
ومن هذا أن تأخر المقصود بالمدح والذم أولىمن تقدمه كقوله نعم الرجل زيد أحسن من قولك زيد نعم الرجل لأنهم يقدمون الأهم وهم في هذا بذكر المدح والذم أهم.
فأما تقديمه في قوله تعالى: {نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} فإن الممدوح هنا بـ"نعم العبد" هو سليمان عليه السلام وقد تقدم ذكره. وكذلك أيوب في الآية الآخرى والمخصوص بالمدح في الآيتين ضمير سليمان وأيوب وتقديره نعم العبد هو إنه أواب.
الرابع عشر: للتنبيه على أنه مطلق لا مقيد.
كقوله تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ}، على القول بأن "الله" في موضع المفعول الثاني لـ"جعل" و"شركاء" مفعول أول ويكون "الجن" في كلام ثان مقدر،.
كأنه قيل: فمن جعلوا شركاء ؟ قيل: الجن وهذا يقتضى وقوع الإنكار على جعلهم "لله شركاء" على الإطلاق فيدخل مشركة غير الجن ولو أخر فقيل: وجعلوا الجن شركاء لله كان الجن مفعولا أولا وشركاء ثانيا فتكون الشركة مقيدة غير مطلقة لأنه جرى على الجن فيكون الإنكار توجه لجعل المشاركة للجن خاصة وليس كذلك وفيه زيادة سبقت.
الخامس عشر: للتنبيه على أن السبب مرتب.
كقوله تعالى: {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ} قدم الجباه ثم الجنوب لأن مانع الصدقة في الدنيا كان يصرف وجهه أولا عن السائل ثم ينوه بجانبه ثم يتولى بظهره.
السادس عشر: التنقل.
وهو أنواع: إما من الأقرب إلى الأبعد، كقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً} قدم ذكر المخاطبين على من قبلهم وقدم الأرض على السماء.
وكذلك قوله: {إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ}، لقصد الترقي.
وقوله: {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}.
وإما بالعكس كقوله في اول الجاثية: {إِِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ}.
وإما من الأعلى كقوله: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ}.
وقوله: {مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ}.
وإما من الأدنى كقوله: {وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً}.
وقوله: {مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً}.
وقوله: {لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ}.
فإن قلت: لم لا اكتفي بنفي الأدنى ليعلم منه نفى الأعلى بطريق الأولى ؟ قلت: جوابه مما سبق من التقديم بالزمان.
وكقوله: {وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ} الآية، وبهذا يتبين فساد استدلال المعتزلة على تفضيل الملك على البشر بقوله: {لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ} فإنهم زعموا أن سياقها يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى إذ لا يحسن أن يقال لا يستنكف فلان عن خدمتك ولا من دونه بل ولا من فوقه.
وجوابه أن هؤلاء لما عبدوا المسيح واعتقدوا فيه الولدية لما فيه من القدرة على الخوارق.
والمعجزات من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيره ولكونه خلق من غير تراب والتزهيد في الدنيا وغالب هذه الامور هي للملائكة أتم وهم فيها أقوى فإن كانت هذه الصفات أوجبت عبادته فهو مع هذه الصفات لا يستنكف عن عبادة الله بل ولا من هو أكبر منه في هذه الصفات للترقي من الأدنى إلى الأعلى في المقصود ولم يلزم منه الشرف المطلق والفضيلة على المسيح.
السابع عشر: الترقي.
كقوله: {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا} الآية، فإنه سبحانه بدأ منها بالأدنى لغرض الترقي لأن منفعة الرابع أهم من منفعة الثالث فهو أشرف منه ومنفعة الثالث أعم من منفعة الثاني ومنفعة الثاني أعم من منفعة الأول فهو أشرف منه.
وقد قرن السمع بالعقل ولم يقرن به البصر في قوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لا يُبْصِرُونَ} وما قرن بالأشرف كان أشرف وحكى ذلك عن علي بن عيسى الربعي.
قال الشيخ أبو الفتح القشيري:.
فإن قيل: قد كان الأولى أن يقدم الوصف الأعلى ثم ما دونه حتى ينتهي إلى أضعفها لأنه إذا بدا بسلب الوصف الأعلى ثم بسلب مادونه كان ذلك أبلغ في الذم.
لأنه لا يلزم من سلب الأعلى سلب ما دونه كما تقول ليس زيد بسلطان ولا وزير ولا أمير ولا وال والغرض من الآية المبالغة في الذم.
قلت: ما ذكرته طريق حسنة في علم المعاني والمقصود من الآية طريقة أخرى وهي أنه تعالى أثبت أن الأصنام التي تعبدها الكفار أمثال الكفار في أنها مقهورة مربوبة ثم حطها عن درجة المثلية بنفي هذه الصفات الثابتة للكفار عنها. وقد علمت أن المماثلة بين الذوات المتنائية إنما تكون باعتبار الصفات الجامعة بينها إذ هي أسباب في ثبوت المماثلة بينها وتقوى المماثلة بقوة أسبابها وتضعف بضعفها فإذا سلب وصف ثابت لإحدى الذاتين عن الأخرى انتفى وجه من المماثلة بينهما ثم إذا سلب وصف من الأول انتفى وجه من المماثلة أقوى من الأول ثم لا يزال يسلب أسباب المماثلة أقواها فأقواها حتى تنتفي المماثلة كلها بهذا التدريج وهذه الطريقة ألطف من سلب أسباب المماثلة أقواها ثم أضعفها فأضعفها.
الثامن عشر: مراعاة الإفراد.
فإن المفرد سابق على الجمع كقوله تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ}، وقوله: {مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ} ولهذا لما عبر عن المال بالجمع أخر عن البنين في قوله: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ}.
ومنه تقديم الوصف بالمفرد على الوصف بالجملة، في قوله: {وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ} وقوله: {وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ}.
التاسع عشر: التحذير منه والتنفير عنه.
كقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} ، قرن الزنى بالشرك وقدمه.
وقوله: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ} قدمهن في الذكر لأن المحنة بهن أعظم من المحنة بالأولاد وفي صحيح مسلم: "ما تركت بعدي [في الناس] فتنة أضر على الرجال من النساء". ومن الحكمة العظيمة أنه بدأ بذكر النساء في الدنيا وختم [الحرث] وهما طرفان متشابهان وفيهما الشهوة والمعاش الدنيوي ولما ذكر بعد ذلك ما أعده للمتقين أخر ذكر الأزواج كما يجب في الترتيب الأخروي وختم بالرضوان. وكم في القرآن من مثل هذا العجب إذا حضر له الذهن وفرغ له الفهم !.
ومنه تقديم نفي الولد على نفي الوالد في قوله: { لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} فإنه لما وقع في الأول منازعة الكفرة وتقولهم اقتضت الرتبة بالطبع تقديمه في الذكر اعتناء به قبل التنزيه عن الوالد الذي لم ينازع فيه أحد من الأمم.
العشرون: التخويف منه.
كقوله تعالى: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ} ونظائره السابقة في الثامن.
الحادي والعشرون: التعجيب من شأنه.
كقوله تعالى: {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ}.
قال الزمخشري: قدم الجبال على الطير لأن تسخيرها له وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في الإعجاز لأنها جماد والطير حيوان ناطق.
قال ابن النحاس: وليس مراد الزمخشري بناطق ما يراد به في حد الإنسان.
الثاني والعشرون: كونه أدل على القدرة.
كقوله تعالى: {فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ}.
والثالث والعشرون: قصد الترتيب.
كما في آية الوضوء فإن ادخال المسح بين الغسلين وقطع النظر عن النظير مع مراعاة ذلك في لسانهم دليل على قصد الترتيب.
وكذلك البداءة في الصفا بالسعي ومثله الكفارة المرتبة في الظهار والقتل.
وهنا قاعدة ذكرها أصحابنا وهي أن الكفارة المرتبة بدأ الله فيها بالأغلظ والمخيرة بدأ فيها بالأخف كما في كفارة اليمين ولهذا حملوا آية المحاربة في قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا}، الآية على الترتيب لا التخيير لأنه بدأ فيها بالأغلظ طردا للقاعدة خلافا لمالك حيث جعلها على التخيير.
الرابع والعشرون: خفة اللفظ.
كما في قولهم: ربيعة ومضر مع أن مضر أشرف لكون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم لأنهم لو قدموا مضر لتوالي حركات كثيرة وذلك يثقل فإذا قدموا ربيعة ووقفوا على مضر بسكون الراء نقص الثقل لقلة الحركات المتوالية.
وقد يكون تقديم الإنس على الجن من ذلك فالإنس أخف لمكان النون والسين المهموسة.
الخامس والعشرون: رعاية الفواصل.
كتأخير الغفور في قوله: {عَفُوٌّ غَفُورٌ} وقوله: {وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً}.
وإن كانت القاعدة في علم البيان تأخير ما هو الأبلغ فإنه يقال عالم نحرير وشجاع باسل وسبق له نظائر.
وكقوله: {خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ}، ولو قال: صلوه الجحيم لأفاد المعنى ولكن يفوت الجمع.
وقيل: فائدته الاختصاص.
وقوله: {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} فقدم [إياه] على [تعبدون] لمشاكلة رءوس الآى.
تنبيه:.
قد يكون في كل واحد مما ذكرنا من الأمثلة سببان فأكثر للتقديم فإما أن يعتقد إعادة الكل أو يرجح بعضها لكونه أهم في ذلك المحل. وإن كانت الأخرى أهم في محل آخر وإذا تعارضت الأسباب روعى أقواها فإن تساوت كان المتكلم بالخيار في تقديم أي الأمرين شاء.
النوع الثاني: مما قدم النية به التأخير.
فمنه ما يدل على ذلك الإعراب كتقديم المفعول على الفاعل في نحو قوله: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}،{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا}، {وَإِذِ ابْتَلَى.
إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ}.
ونحوه مما يجب في الصناعة النحوية كذلك ولكن ذلك لقصد الحصر.
كتقديم المفعول. كقوله: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي}{قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ}.
وكتقديم الخبر على المبتدأ في قوله: {وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ} ولو قال:" وظنوا أن حصونهم مانعتهم " لما أشعر بزيادة وثوقهم بمنعها إياهم.
وكذا: {أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي} ولو قال:" أأنت راغب عنها " ؟ ما أفادت زيادة الإنكار على إبراهيم.
وكذلك: {وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ولم يقل: فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة وكان يستغنى عن الضمير لأن هذا لا يفيد اختصاص الذين كفروا بالشخوص.
ومنه ما يدل على المعنى، كقوله تعالى: {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا}، قال البغوي: هذا أول القصة وإن كانت مؤخرة في التلاوة.
وقال الواحدي: كان الاختلاف في القاتل قبل ذبح البقرة وإنما أخر في الكلام لأنه سبحانه لما قال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ} الآية علم المخاطبون أن البقرة لا تذبح إلا للدلالة على قاتل خفيت عينه عليهم فلما استقر علم هذا في نفوسهم أتبع بقوله: {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا} على جهة التوكيد لا أنه عرفهم الاختلاف في القاتل بعد أن دلهم على ذبح البقرة وقيل إنه من المؤخر الذي يراد به التقدم،.
وتأويله: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فسألتم موسى فقال لكم: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}.
وأما الزمخشري ففي كلامه ما يدل على أن إيرادها إنما كان يتأتى على الوجه الواقع في القرآن لمعنى حسن لطيف استخرجه وأبداه.
ومنه قوله تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} وأصل الكلام هواه إلهه كما تقول اتخذ الصنم معبودا لكن قدم المفعول الثاني على الأول للعناية كما تقول علمت منطلقا زيدا لفضل عنايتك بانطلاقه.
ومنه قوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ} الآية، أي أنزله قيما ولم يجعل له عوجا قاله جماعة، منهم الواحدي.
ورده فخر الدين في تفسيره بأن قوله: {وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّماً} معناه أنه كامل في ذاته وأن " قيما " معناه أنه مكمل لغيره وكونه كاملا في ذاته سابق على كونه مكملا لغيره لأن معنى كونه " قيما " أنه قائم بمصالح الغير. قال: فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح ما ذكر في الآية وما ذكر من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه. انتهى.
وهذا فهم عجيب من الإمام لأن القائل بالتقديم والتأخير لا يقول بأن كونه غير ذي عوج متأخر عن كونه قيما في المعنى وإنما الكلام في ترتيب اللفظ لأجل الإعراب وقد يكون أحد المعنيين ثابتا قبل الآخر ويذكر بعده.
وأيضا فإن هذا البحث إنما هو على تفسير القيم بالمستقيم فأما إذا فسر بالقيام على غيره فلا نسلم أن القائل يقول بالتقديم والتأخير.
وهاهنا أمران أمران:.
أحدهما: أن الأظهر جعل هذه الجملة أعنى قوله: {وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّماً} من جملة صلة "الذي" وتمامها وعلى هذا لا موضع لها من الإعراب لوجهين: أحدهما: أنها في حيز الصلة لأنها معطوفة عليها. والثاني : أنها اعتراض بين الحال وعاملها ويجوز في الجملة المذكورة أن يكون موضعها النصب على أنها حال من الكتاب والعامل فيها " أنزل ".
قاله جماعة، وفيه نظر.
وأما قوله:[ قيما ] فيجوز في نصبه وجوه:.
أحدها:- وهو قول الأكثر - أنه منصوب على الحال من [الكتاب] والعامل فيه [ أنزل ] وفي الكلام تقديم وتأخير وتقديره:[ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا ] فتكون الجملة على هذا اعتراضا.
والثاني: أن يكون منصوبا بفعل مقدر وتقديره: ولكن جعله قيما فيكون مفعولا للفعل المقدر.
والثالث : أن يكون حالا من الضمير في قوله: {وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا} وتكون حالا مؤكدة.
واختار صاحب الكشاف أن يكون [قيما] مفعولا لفعل مقدر كما ذكرناه لأن الجملة التي قبلها عنده معطوفة على الصلة و[قيما] من تمام الصلة وإذا كان حالا يكون فيه فصل بين بعض الصلة وتمامها فكان الأحسن جعله معمولا لمقدر.
وقال جماعة منهم ابن المنير في تفسير البحر بعد نقله كلام الزمخشري: وعجيب من كونه لم يجعل الفاصل المذكور حالا أيضا ولا فصل بل هما حالان متواليان من شيء واحد والتقدير أنزل الكتاب غير معوج.
وهذا القول - وهو جعل الجملة حالا - قد ذكره جماعة قبل ابن المنير والظاهر أن الزمخشري لم يرتض هذا القول لأن جعل الجملة حالا يفيده لا ما يفيد العطف من نفي العوج عن الكتاب مطلقا غير مقيد بالإنزال وهو المقصود فالفائدة التي هي أتم إنما تكون على تقدير استقلال الجملة كيف والقول بالتقديم والتأخير منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما نقله الطبري وغيره.
وقال الواحدي: هو قول جميع أهل اللغة والتفسير والزمخشري ربما لاحظ هذا المعنى ولم يمنع جواز غير ما قال لكن ما قال هو الأحسن.
وقال غير ابن المنير في الاعتراض على الزمخشري: إن الجملة وإن كانت مستقلة فهي في حيز الصلة للعطف فلم يقع فصل ويؤيد ما ذكره صاحب الكشاف أن بعض القراء يسكت عند قوله:[ عوجا ]ويفصل بينه وبين " قيما " بسكتة لطيفة وهي رواية حفص عن عاصم وذلك يحتمل أن يكون لما ذكرنا من تقدير الفصل وانقطاع الكلام عما قبله قال ابن المنير وتحتمل السكتة وجها آخر وهو أن يكون ذلك لرفع توهم أن يكون قيما نعتا للعوج لأن النكرة تستدعي النعت غالبا وقد كثر في كلامهم إيلاء النكرة الجامدة نعتها كقوله: {صِرَاطاً مُسْتَقِيماً}، و{قُرْآناً عَرَبِيّاً} فإذا ولي النكرة الجامدة اسم مشتق نكرة ظهر فيه معنى الوصف فربما خيف اللبس في جعل [قيما] نعتا لـ[عوج] فوقع اللبس بهذه السكتة وهذا أيضا فيه نظر لأن ذلك إنما يتوهم فيما يصلح أن يكون وصفا ولا يصلح قيما أن يكون وصفا ل عوج فإن الشيء لا يوصف بضده لأن العوج لا يكون قيما والأولى ما ذكرناه أولا
الثاني: نقل الإمام عن بعضهم أن قيما بدل من قوله عوجا وهو مشكل لأنه لا يظهر له وجه.
وقوله تعالى: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا} قيل: التقدير: لقد همت به لولا أن رأى برهان ربه وهم بها وهذا أحسن لكن في تأويله قلق ولا يحتاج إلى هذا التأويل إلا على قول من قال: إن الصغائر يجوز وقوعها منهم.
وقوله: {فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ} قيل: أصله: فبشرناها بإسحاق فضحكت. وقيل: ضحكت أي حاضت بعد الكبر عند البشرى فعادت إلى عادات النساء من الحيض والحمل والولادة.
وقوله: {فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا}، قدم علىما بعده وهو مؤخر عنه في المعنى لأن ذلك يحصل للتوافق.
وقوله: {فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى} أي أحوى غثاء أي أخضر يميل إلى السواد والموجب لتأخير أحوى رعاية الفواصل.
وقوله: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً} قال ابن برهان النحوي: أصله: ومن يبتغ دينا غير الإسلام.
وقوله: {وَغَرَابِيبُ سُودٌ} قال أبو عبيد: الغربيب: الشديد السواد ففي الكلام تقديم وتأخير وقال صاحب [العجائب والغرائب]: قال ابن عيسى:.
الغربيب: الذي لونه لون الغراب فصار كأنه غراب. قال: والغراب يكون أسود وغير أسود وعلى هذا فلا تقديم ولا تأخير فيه.
وقوله: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ} على قول من يقول إن الذكر هنا القرآن.
وقوله: {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا}.
وقوله: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}.
وقوله: {فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا} أي فعقروها ثم كذبوه في عقرها وفي إجابتهم.
وقوله: {ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ} تقديره: ثم قضى أجلا وعنده أجل مسمى أي وقت مؤقت.
وقوله: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ} أ ي الأوثان من الرجس.
{هُدىً وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} أي يرهبون ربهم.
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} أي الذين هم حافظون لفروجهم.
{فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ} أي مخلف رسله وعده.
{بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} أي بل الإنسان بصير على نفسه في شهود جوارحه عليه.
{خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} خلق العجل من الإنسان.
{وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلٌ مُسَمّىً} أي ولولا.
كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب لازما لهم.
{أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ} أي كيف مده ربك.
{وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} أي لشديد لحب الخير.
{وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ.} أي زين للمشركين شركاؤهم قتل أولادهم لأن الشياطين كانوا يحسنون لهم قتل بناتهم خشية العار.
وقوله: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ}.
وقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} أي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة.
وقوله: {مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ} تقديره: مثل الذين كفروا بربهم كرماد اشتدت به الريح.
وقوله: {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ} أي فأنا عدو آلهتهم وأصنامهم وكل معبود يعبدونه من دون الله.
وقوله: { وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا} أي فزعوا وأخذوا فلا فوت لأن الفوت يكون بعد الأخذ.
وقوله: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ، يعني القيامة. {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ}.
وذلك يوم القيامة. ثم قال: {عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ} والنصب والعمل يكونان في الدنيا فكأنه على التقديم والتأخير معناه وجوه عاملة ناصبة ويوم القيامة خاشعة والدليل عليه قوله: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ}.
وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ}، تقديره: لمقت الله إياكم في الدنيا حين دعيتم إلا الإيمان فكفرتم ومقته إياكم اليوم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ دعيتم إلى النار.
وقوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ، لأن الفجر ليس له سواد والتقدير حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل أي حتى يتبين لكم بياض الصبح من بقية سواد الليل.
وقوله: {وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ}.
وقوله: {كَأَنْ لَمْ تَكُنْ} منظوم بقوله: {قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ} لأنه موضع الشماتة.
وقوله: {وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ}، أي اثنين إلهين لأن اتخاذاثنين يقع على ما يجوز وما لايجوز و"إلهين" لا يقع إلا على ما لا يجوز ف إلهين أخص فكان جعله صفة أولى.
النوع الثالث: ما قدم في آية وأخر في أخرى.
فمن ذلك قوله في فاتحة الفاتحة: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} وفي خاتمة الجاثية: {فَلِلَّهِ الْحَمْدُ} فتقديم "الحمد" في الأول جاء على الأصل والثاني على تقدير الجواب فكأنه قيل عند وقوع الأمر لمن الحمد ومن أهله فجاء الجواب على ذلك نظيره: {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ} ثم قال: {لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ}.
وقوله في سورة يس: {وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى} قدم المجرور على المرفوع لاشتمال ما قبله من سوء معاملة أصحاب القرية الرسل وإصرارهم على تكذيبهم فكان مظنة التتابع على مجرى العبارة تلك القرية ويبقى مخيلا في فكره أكانت كلها كذلك أم كان فيها.. على خلاف ذلك، بخلاف ما في سورة القصص.
ومنها قوله في سورة النمل: {لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ} ، وفي سورة المؤمنين: {لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ} ، فإن ما قبل الأولى {أَإِذَا كُنَّا تُرَاباً وَآبَاؤُنَا} وما قبل الثانية {أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً}، فالجهة المنظور فيها هناك كون أنفسهم وأبائهم ترابا والجهة المنظور فيها هنا كونهم ترابا وعظاما ولا شبهة أن الأولى أدخل عندهم في تبعيد البعث.
ومنها قوله في سورة المؤمنين: {وَقَالَ الْمَلأُُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا}، فقدم المجرور على الوصف لأنه لو أخبر عنه - وأنت تعلم أن تمام الوصف بتمام ما يدخل عليه الموصوف وتمامه {وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} - لاحتمل أن يكون من نعيم الدنيا واشتبه الأمر في القائلين أهم من قومه أم لا ؟ بخلاف قوله في موضع آخر منها: {فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ} فإنه جاء على الأصل.
ومنها قوله في سورة طه: {آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى}.
بخلاف قوله في سورة الشعراء: {رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ}.
ومنها قوله: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ}، وقال في سورة الإسراء: {نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ} قدم المخاطبين في الأولى دون الثانية لأن الخطاب في الأولى في الفقراء بدليل قوله :{مِنْ إِمْلاقٍ} فكان رزقهم عندهم أهم من رزق أولادهم فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم والخطاب في الثانية للأغيناء بدليل: {خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} فإن الخشية إنما تكون مما لم يقع فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم لأنه حاصل فكان أهم فقدم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم.
ومنها ذكر الله في أواخر سورة الملائكة: {إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} فقدم ذكر السموات لأن معلوماتها أكثر فكان تقديمها أدل على صفة العالمية ثم قال: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ} فبدأ بذكر الأرض لأنه في.
سياق تعجيز الشركاء عن الخلق والمشاركة وأمر الأرض في ذلك أيسر من السماء بكثير فبدأ بالأرض مبالغة في بيان عجزهم لأن من عجز عن أيسر الأمرين كان عن أعظمهما أعجز ثم قال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولا}، فقدم السموات تنبيها على عظم قدرته سبحانه لأنه خلقها أكبر من خلق الأرض كما صرح به في سور المؤمن ومن قدر على إمساك الأعظم كان على إمساك الأصغر أقدر.
فإن قلت: فهلا اكتفى من ذكر الأرض بهذا التنبيه البين الذي لا يشك فيه أحد !.
قلت: أراد ذكرها مطابقة لأنه على كل حال أظهر وأبين فانظر أيها العاقل حكمة القرآن وما أودعه من البيان والتبيان تحمد عاقبة النظر وتنتظر خير منتظر!.
ومن أنواعه أن يقدم اللفظ في الآية ويتأخر فيها لقصد أن يقع البداءة والختم به للاعتناء بشأنه وذلك كقوله تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ}.
وقوله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا} إلى قوله: {قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ}.
وكذلك قوله: {إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ} فإنه لولا ما أسلفناه لقيل ما تكتمون وتبدون لأن الوصف بعلمه.
أمدح كما قيل: {يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ} و{عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ} {وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ}.
فإن قلت: فقد قال تعالى: {يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى}.
قلت لأجل تناسب رءوس الآى.
ومنها أن يقع التقديم في موضع والتأخير في آخر، واللفظ واحد، والقصة واحدة، للتفنن في الفصاحة وإخراج الكلام على عدة أساليب كما في قوله تعالى: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ} وقوله: {وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً}.
وقوله: {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ} وقوله: {وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ} قال الزمخشري في كشافه القديم علم بذلك أن كلا الطريقين داخل تحت الحسن وذلك لأن العطف في المختلفين كالتثنية في المتفقين فلا عليك أن تقدم أيهما شئت فإنه حسن مؤد إلى الغرض. وقد قال سيبويه: ولم يجعل للرجل منزلة بتقديمك إياه بكونه أولى بها من الجائي كأنك قلت: مررت بهما يعني في قولك مررت برجل وجاءني إلا أن الأحسن تقديم الأفضل فالقلب رئيس الأعضاء والمضغة لها الشأن ثم السمع طريق إدرك وحي الله وكلامه الذي قامت به السماوات والأرض وسائر العلوم التي هي الحياة كلها.
قلت: وقد سبق توجيه كل موضع بما ورد فيه من الحكمة.
القلب:.
وفي كونه من أساليب البلاغة خلاف فأنكره جماعة منهم حازم في كتاب: "منهاج البلغاء" وقال: إنه مما يجب أن ينزه كتاب الله عنه لأن العرب إن صدر ذلك منهم فبقصد العبث أو التهكم أو المحاكاة أو حال اضطرار والله منزه عن ذلك.
وقبله جماعة مطلقة بشرط عدم اللبس كما قاله المبرد في كتاب: "ما اتفق لفظه واختلف معناه".
وفصل آخرون بين أن يتضمن اعتبارا لطيفا فبليغ وإلا فلا ولهذا قال ابن الضائع: يجوز القلب على التأويل ثم قد يقرب التأويل فيصح في فصيح الكلام وقد يبعد فيختص بالشعر.
وهو أنواع:.
أحدها: قلب الإسناد.
وهو أن يشمل الإسناد إلى شيء والمراد غيره كقوله تعالى: {مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ} إن لم تجعل الباء للتعدية لأن ظاهره أن المفاتح تنوء بالعصبة ومعناه أن العصبة تنوء بالمفاتح لثقلها فأسند " لتنوء " إلى "المفاتح" والمراد إسناده إلى العصبة.
لأن الباء للحال والعصبة مستصحبة المفاتح لا تستصحبها المفاتيح وفائدته المبالغة يجعل المفاتح كأنها مستتبعة للعصبة القوية بثقلها.
وقيل: لا قلب فيه والمراد والله أعلم أن المفاتح تنوء بالعصبة أي تميلها من نقلها وقد ذكر هذا الفراء وغيره.
وقال ابن عصفور: والصحيح ما ذهب إليه الفارسي أنها بالنقل ولا قلب والفعل غير متعد فصار متعديا بالباء لأن [ناء] غير متعد يقال: ناء النجم أي نهض ويقال: ناء أي مال للسقوط فإذا نقلت الفعل بالباء قلت: نؤت به أي أنهضته وأملته للسقوط فقوله: {لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ} أي تميلها المفاتح للسقوط لثقلها.
قال: وإنما كان مذهب الفارسي أصح لأن نقل الفعل غير المتعدي بالباء مقيس والقلب غير مقيس فحمل الآية على ما هو مقيس أولى.
ومنه قوله تعالى: {خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} أي خلق العجل من الإنسان قاله ثعلب وابن السكيت.
قال الزجاج: ويدل على ذلك: {وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً}.
قال ابن جنى: والأحسن أن يكون تقديره: خلق الإنسان من العجلة لكثرة فعله إياه واعتماده له وهو أقوى في المعنى من القلب لأنه أمر قد اطرد واتسع فحمله على القلب يبعد في الصنعة ويضعف المعنى.
ولما خفي هذا على بعضهم قال إن العجل هاهنا الطين قال: ولعمري إنه في اللغة كما ذكر غير أنه ليس هنا إلا نفس العجل ألا ترى إلى قوله عقبه: {سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ}، ونظيره قوله: { وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً}{وَخُلِقَ الإِنْسَانُ.
ضَعِيفاً} لأن العجلة ضرب من الضعف لما تؤذن به الضرورة والحاجة.
وقيل في قوله: {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ} أي إنه من المقلوب، وأنه {وجاءت سكرة الحق بالموت} وهكذا في قراءة أبي بكر.
مثله: {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ}، قال الفراء: أي لكل أمر كتبه الله أجل مؤجل. وقيل في قوله: {وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ} : هو من المقلوب أي يريد بك الخير ويقال: أراده بالخير وأراد به الخير.
وجعل ابن الضائع منه: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} ، قال: فآدم صلوات الله على نبينا وعليه هو المتلقي للكلمات حقيقة ويقرب أن ينسب التلقي للكلمات لأن من تلقى شيئا أو طلب أن يتلقاه فلقيه كان الآخر أيضا قد طلب ذلك لأنه قد لقيه قال: ولقرب هذا المعنى قرىء بالقلب.
وجعل الفارسي منه قوله تعالى: {فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ} أي فعميتم عليها.
وقوله: {فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ}.
وقوله: {وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً}، {وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ} أي بلغت الكبر.
وقوله: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} وقوله: {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي.
إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ} ، فإن الأصنام لا تعادي وإنما المعنى فإني عدو لهم مشتق من عدوت الشيء إذا جاوزته وخلفته وهذا لا يكون إلا فيمن له إرادة وأما عاديته فمفاعة لا يكون إلا من اثنين.
وجعل منه بعضهم: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} أي إن حبه للخير لشديد.
وقيل ليس منه لأن المقصود منه أنه لحب المال لبخيل والشدة البخل أي من أجل حبه للمال يبخل.
وجعل الزمخشري منه قوله تعالى: {وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ} كقوله: عرضت الناقة على الحوض لأن المعروض ليس له اختيار وإنما الاختيار للمعروض عليه فإنه قد يفعل ويريد وعلى هذا فلا قلب في الآية لأن الكفار مقهورون فكأنهم لا اختيار لهم والنار متصرفة فيهم وهو كالمتاع الذي يقرب منه من يعرض عليه كما قالوا: عرضت الجارية على البيع.
وقوله: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ} ومعلوم أن التحريم لا يقع إلا على الملكف فالمعنى وحرمنا على المراضع أن ترضعه ووجه تحريم إرضاعه عليهن إلا يقبل إرضاعهن حتى يرد إلى أمه.
وقوله تعالى: {وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ}، وقيل: الأصل وما تخدعهم إلا أنفسهم لأن الأنفس هي المخادعة والمسولة، قال تعالى: {بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ}.
ورد بأن الفاعل في مثل هذا هوالمفعول في المعنى وأن التغاير في اللفظ فعلى هذا يصح إسناد الفعل إلى كل منهما ولا حاجة إلى القلب.
الثاني: قلب المعطوف.
إما بأن تجعل المعطوف عليه معطوفا والمعطوف معطوفا عليه كقوله تعالى: {فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ}، حقيقته فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم لأنه نظره ما يرجعون من القول غير متأت مع توليه عنهم. وما يفسر به التولي من أنه يتوارى في الكوة التي ألقى منها الكتاب مجاز والحقيقة راجحة عليه.
وقوله: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} أي تدلى فدنا لأنه بالتدلي نال الدنو والقرب إلى المنزلة الرفيعة وإلى المكانة لا إلى المكان.
وقيل: لا قلب، والمعنى: ثم أراد الدنو وفي صحيح البخاري: "{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} المعنى فإذا استعذت فأقرأ ".
وقوله: {وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا}، وقال صاحب الإيضاح: لا قلب فيه لعدم تضمنه اعتبارا لطيفا.
ورد بتضمنه المبالغة في شدة سورة البأس يعنى هلكت بمجرد توجه الناس إليها ثم جاءها.
الثالث: العكس.
العكس، وهو أمر لفظي كقوله: {مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ}.
وقوله: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}.
{لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}.
{يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ}.
الرابع: المستوى.
وهو أن الكلمة او الكلمات تقرأ من أولها إلى آخرها ومن آخرها إلى أولها لا يختلف لفظها ولا معناها كقوله: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ}.
{كُلٌّ فِي فَلَكٍ}.
الخامس: مقلوب البعض.
وهو أن تكون الكلمة الثانية مركبة من حروف الكلمة الأولى مع بقاء بعض حروف الكلمة الأولى كقوله تعالى: {فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائيلَ} فـ"بني" مركب من حروف "بين" وهو مفرق إلا أن الباقي بعضها في الكلمتين وهو أولها.
المدرج.
هذا النوع سميته بهذه التسمية بنظير المدرج من الحديث وحقيقته في أسلوب القرآن أن تجيء الكلمة إلى جنب أخرى كأنها في الظاهر معها وهي في الحقيقة غير متعلقة بها كقوله تعالى ذاكرا عن بلقيس: {إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} هو من قول الله لا من قول المرأة.
ومنه قوله تعالى: {الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}.
انتهى قول المرأة ثم قال يوسف عليه السلام: { ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ} معناه ليعلم الملك أني لم أخنه.
ومنه: {قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا} تم الكلام فقالت الملائكة: {هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ}.
وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} فهذه صفة لأتقياء المؤمنين ثم قال: {يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ} فهذا يرجع إلى كفار مكة تمدهم إخوانهم من الشياطين في الغي.
وقوله: {يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ} ثم أخبر عن فرعون متصلا: {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ}.
وقوله: {هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ} فالظاهر أن الكلام كله من كلام الزبانيةوالأمر ليس كذلك.
وقوله: {إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} من كلامه تعالى وقال: {إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}.
الترقي.
كقوله تعالى: {لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ}،{لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً}.
فإن قيل فقد ورد: {فَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً} والغالب أن يقدم في القليل على الكثير مع أن الظلم منع للحق من أصله والهضم منع له من وجه كالتطفيف فكان يناسبه تقديم الهضم.
قلت: لأجل فواصل الاى فإنه تقدم قبله: {وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً} فعدل عنه في الثاني كيلا يكون أبطأ وقد سيقت أمثلة الترقي في أسباب التقديم.
الاقتصاص.
ذكره أبو الحسين بن فارس وهو أن يكون كلام في سورة مقتصا من كلام في سورة آخرى أو في السورة نفسها ومثله بقوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ}، والآخرة دار ثواب لا عمل فيها فهذا مقتص من قوله: {وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى}.
ومنه قوله تعالى: {وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ} مأخوذ من قوله تعالى: {فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ}.
وقوله: {ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيّاً}.
فأما قوله تعالى: {وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ} فيقال: إنها مقتصة من أربع آيات لأن الإشهاد أربعة:.
الملائكة عليهم السلام في قوله: {وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ}.
والأنبياء عليهم السلام لقوله تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً}.
وأمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}.
والأعضاء لقوله: {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.
ومنه قوله تعالى: {إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ} وقرئت مخففة ومثقلة فمن شدد فهو من [ نَدَّ ] إذا نفر وهو مقتص من قوله: {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ} الآية. ومن خفف فهو تفاعل من النداء مقتص من قوله تعالى: {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ}.
الألغاز.
واللغز الطريق المنحرف سمى به لانحرافه عن نمط ظاهر الكلام ويسمى ايضا أحجية لأن الحجى هو العقل وهذا النوع يقوي العقل عند التمرن والارتماض بحله والفكر فيه.
وذكر بعضهم أنه وقع في القرآن العظيم وجعل منه ما جاء في أوائل السور من الحروف المفردة والمركبةالتي جهل معناها وحارت العقول في منتهاها.
ومنه قوله تعالى في قصة إبراهيم لما سئل عن كسر الأصنام وقيل له: أنت فعلته فقال: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} قابلهم بهذه المعارضة ليقيم عليهم الحجة ويوضح لهم المحجة.
وكذلك قول نمروذ: {أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ} أتى باثنين فقتل أحدهما وأرسل الآخرة فإن هذه مغالطة.
الاستطراد.
وهو التعريض بعيب إنسان بذكر عيب غيره كقوله تعالى: {وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ}.
وكقوله: {فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ} وقوله: {أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ}.
الترويد.
وهو أن يعلق المتكلم لفظة من الكلام ثم يردها بعينها ويعلقها بمعنى آخر كقوله: {حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ} الآية فإن الأول مضاف إليه والثاني مبتدأ.
وقوله: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ. يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}.
وقوله: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ}.
وقد يحذف أحدها ويضمر أولا يلاحظ على الخلاف في قوله تعالى: {لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ}.
التغليب.
وحقيقته إعطاء الشيء حكم غيره. وقيل ترجيح أحد المغلوبين على الآخر أو إطلاق لفظة عليهما إجراء للمختلفين مجرى المتفقين.
وهو أنواع:.
الأول : تغليب المذكر.
كقوله تعالى: {وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} غلب المذكر لأن الواو جامعة لأن لفظ الفعل مقتص ولو أردت العطف امتنع.
وقوله: {وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ}.
وقوله: {إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ} والأصل:" من القانتات والغابرات " فعدت الأنثى من المذكر بحكم التغليب.
هكذا قالوا، وهو عجيب فإن العرب تقول نحن من بني فلان لا تريد إلا موالاتهم والتصويب لطريقتهم وفي الحديث الصحيح في الأشعريين: " هم مني وأنا منهم " فقوله سبحانه: {مِنَ الْقَانِتِينَ} ولم يقل: من "القانتات" إيذانا بان وضعها في العباد جدا واجتهادا وعلما وتبصرا ورفعة من الله لدرجاتها في أوصاف الرجال القانتين وطريقهم.
ونظيره ولكن بالعكس قول عقبة بن أبي معيط لأمية بن خلف لما أجمع القعود.
عن وقعة بدر لأنه كان شيخا فجاء بمجمرة فقال: يا أبا علي استجمر فإنما أنت من النساء فقال: قبحك الله وقبح ما جئت به ثم تجهز.
ونازعهم بعضهم في ذلك من وجه آخر فقال: يحتمل ألا يكون [من] للتبعيض بل لابتداء الغاية أي كانت ناشئة من القوم القانتين لأنها من أعقاب هارون أخي موسى عليه السلام.
الثاني: تغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب.
فيقال: أنا وزيد فعلنا وأنت وزيد تفعلان ومنه قوله تعالى: {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} بتاء الخطاب غلب جانب [ أنتم ] على جانب [ قوم ] والقياس أن يجيء بالياء لأنه وصف القوم وقوم اسم غيبة ولكن حسن آخر الخطاب وصفا ل قوم لوقوعه خبرا عن ضمير المخاطبين. قال ابن الشجري.
ولو قيل: إنه حالل لـ {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً} لن في الضمير الخطاب معنى الإشارة لملازمته لها أو لمعناها لكان متجها وإن لم تساعده الصناعة لكن يبعده أن المراد وصفهم بجهل مستمر لا مخصوص بحال الخطاب ولم يقل:[ جاهلون ] إيذانا بأنهم يتجددون عند كل مصيبة لطلب آيات جهلهم.
وقال أبو البركات بن الأنباري: ولو قيل: إنما قال:[ تجهلون] بالتاء – لأن [ قوم ] هو [ أنتم ] في المعنى فلذلك، قال:[ تجهلون ] حملا على المعنى - لكان حسنا ونظيره قوله:
*أنا الذي سمتني أمي حيدره*
بالياء حملا على [ أنا ] لأن الذي هو[ أنا ] في المعنى.
ومنه قوله تعالى: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ} غلب فيه جانب [ أنت ]على جانب [مَن] فاسند إليه الفعل وكان تقديره: فاستقيموا فغلب الخطاب على الغيبة لأن حرف العطف فصل بين المسند إليهم الفعل فصار كما ترى. قال صاحب الكشاف تقديره:فاستقم كما أمرت وليستقم كذلك من تاب معك.
وما قلنا أقل تقديرا من هذا فاختر أيهما شئت.
وقوله تعالى: {قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ} فأعاد الضمير بلفظ الخطاب وإن كان [من تبعك] يقتضى الغيبة تغليبا للمخاطب وجعل الغائب تبعا له كما كان تبعا له في المعصية والعقوبة فحسن أن يجعل تبعا له في اللفظ وهو من محاسن ارتباط اللفظ بالمعنى.
وكقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} فإن الخطاب في [ لعلكم ] متعلق بقوله [خلقكم] لا بقوله [اعبدوا] حتى يختص بالناس المخاطبين إذ لا معنى لقوله [اعبدوا لعلكم تتقون].
ومنه قوله تعالى: {وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} فيمن قرأ بالتاء.
ويجوز أن يكون المراد بـ[ما تعملون] الخلق كلهم والمخاطب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكل سامع أبدا فيكون تغليبا ولا يجوز أن يعتبر خطاب من سواه بدونه من غير اعتبار التغليب لامتنان أن يخاطب في كلام واحد اثنان أو أكثر من غير عطف او تثنية أو جمع.
ومنه قوله تعالى:.......
الثالث: تغليب العاقل على غيره.
بأن يتقدم لفظ يعم من يعقل ومن لا يعقل فيطلق اللفظ المختص بالعاقل على الجميع كما تقول: "خلق الله الناس والأنعام ورزقهم"، فإن لفظ [هم] مختص بالعقلاء.
ومنه قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ} لما تقدم لفظ الدابة والمراد بها عموم من يعقل ومن لا يعقل غلب من يعقل فقال: {فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي}.
فإن قيل: هذا صحيح في {فمنهم] لأنه لمن يعقل وهو راجع إلى الجميع فلم قال: [من] وهو لا يقع على العام بل خاص بالعاقل ؟.
قلت:[ مَن ] هنا بعض [ هم ]وهو ضمير من يعقل.
فإن قلت: فكيف يقع على بعضه لفظ ما لا يعقل ؟.
قلت: من هنا قال أبو عثمان: إنه تغليب من غير عموم لفظ متقدم فهو بمنزله من يقول رأيت ثلاثة زيدا وعمرا وحمارا.
وقال ابن الصائغ:[ هم ] لا تقع إلا على من يعقل فلما أعاد الضمير على كل دابة غلب من يعقل فقال:[ هم ] ومن بعض هذا الضمير وهو للعاقل فلزم أن يقول [من] فلما قال: بوقوع التغليب في الضمير صار ما يقع عليه حكمه حكم العاقلين فتمم ذلك بأن أوقع [من].
وقوله تعالى حاكيا عن السماء والأرض: {قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} ، إنما جمعهما جمع.
السلامة، ولم يقل [طائعين] ولا [طائعات] لأنه أراد: ائنيا بمن فيكم من الخلائق طائعين فخرجت الحال على لفظ الجمع وغلب من يعقل من الذكور.
وقال بعض النحويين: لما أخبر عنهما أنهما يقولان كما يقول الآدميون أشبهتا الذكور من بني آدم. وإنما قال: [طائعين] ولم يقل: [مطيعين] لنه من طعنا أي أنقدنا وليس من أطعنا يقال طاعت الناقة تطوع طوعا إذا انقادت.
وقوله تعالى: {بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ} ، قيل: أوقع [ما] لأنها تقع على أنواع من يعقل لأنه إذا اجتمع من يعقل ومالا يعقل فغلب مالا يعقل كان الأمر بالعكس ويناقضه {كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ}.
وقال الزمخشري جاء بـ[ما] تحقيرا لشأنهم وتصغيرا قال:[ له قانتون] تعظيم.
ورد عليه ابن الضائع بصحة وقوعها على الله عز وجل قال: وهذا غاية الخطأ، وقوله في دعاء الأصنام: {هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ}.
وقوله: {وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا} وأما قوله: {فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} وقوله: {فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنْطِقُونَ}.
{إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ}.
{لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا}.{يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ}.
لما أخبر عنها باخبار الآدميين جرى ضميرها على حد من يعقل وكذا البواقي.
فإن قيل: فقد غلب غير العاقل على العاقل في قوله: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ} فإنه لو غلب العاقل على غير العاقل لآتى بـ[مَن].
فالجواب أن هذا الموضع غلب فيه من يعقل وعبر عن ذلك ب ما لأنها واقعة على أجناس من يعقل خاصة كهذه الآية.
قوله: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ} ولم يقل [ومن فيهن] قيل: لأن كلمة [ما] تتناول الأجناس كلها تناولا عاما باصل الوضع و[من] لا تتناول غير العقلاء بأصل الوضع فكان استعمال [ما] هنا أولى.
وقد يجتمع في لفظ واحد تغليب المخاطب على الغائب والعقلاء على غيرهم، كقوله: {جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَأُكُمْ فِيهِ} ، أي خلق لكم أيها الناس من جنسكم ذكورا وإناثا وخلق الأنعام أيضا من أنفسها ذكورا وإناثا يذرؤكم أي ينبتكم ويكثركم أيها الناس والأنعام في هذا التدبير والجعل فهو خطاب للجميع للناس المخاطبين وللأنعام المذكور بلفظ الغيبة ففيه تغليب المخاطب على الغائب وإلا لما صح ذكر الجميع - أعنى الناس والأنعام - بطريق الخطاب لأن الأنعام غيب [وفيه] تغليب العقلاء على غيرهم وإلا لما صح خطاب الجمع بلفظ [كم] المختص بالعقلاء ففي لفظ [كم] تغليبان ولولا التغليب لكان القياس أن يقال: يذرؤكم وإياها هكذا قرره السكاكي والزمخشري.
ونوزعا فيه بأن جعل الخطاب شاملا للأنعام تكلف لا حاجة إليه لأن الغرض إظهار القدرة وبيان الألطاف في حق الناس فالخطاب مختص بهم والمعنى: يكثركم.
أيها الناس في التدبير حيث مكنكم من التوالد والتناسل وهيأ لكم من مصالحكم ما تحتاجون إليه في ترتيب المعاش وتدبير التوالد وجعلها أزواجا تبقى ببقائكم وعلى هذا يكون التقدير: وجعل لكم من الآنعام أزواجا وهذا أنسب بنظم الكلام مما قرروه وهو جعل الأنعام أنفسها أزواجا.
وقوله: {يَذْرَأُكُمْ فِيهِ} أي في هذا التدبير، كأنه محل لذلك ولم يقل [به] كما قال: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} لأنه مسوق لإظهار الاقتدار مع الوحدانية فأسقط السببية وأثبت [في] الظرفية وهذا وجه من إعجاز قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} لأن الحياة من شأنها الاستناد إليه سبحانه لا إلى غيره فاختيرت [في] على الباء لأنه مسوق لبيان الترغيب والمعنى مفهوم والقصاص مسوق للتجويز وحسن المشروعية، {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}.
الرابع: تغليب المتصف بالشيء على ما لم يتصف به.
كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا} قيل: غلب غير المرتابين علىالمرتابين واعترض بقوله تعالى: {وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} وهذا خطاب للكفار فقط قطعا فهم المخاطبون أولا بذلك ثم إن كنتم صادقين لا يتميز فيها التغليب ثم هي شاهدة بأن المتكلم معهم يخص.
الجاحدين بقوله :{إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} وإذا لم يكن الخطاب إلا فيهم فتغليب حال من لم يدخل في الخطاب لا عهد به في مخاطبات العرب.
الخامس: تغليب الأكثر على الأقل.
بأن ينسب إلى الجميع وصف يختص بالأكثر كقوله تعالى: {لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا} أدخل شعيب عليه السلام في قوله :{لَتَعُودُنَّ} بحكم التغليب، إذ لم يكن في ملتهم أصلا حتى يعود إليها ومثله قوله :{إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ} ، واعترض بأن عاد بمعنى صار لغة معروفة، وأنشدوا:
فإن تكن الأيام أحسن مرة ... إلى فقد عادت لهن ذنوب
ولا حجة فيه لجواز أن يكون ضمير الأيام فاعل عادت وإنما الشاهد في قول أمية:
تلك المكارم لا قعبان من لبن ... شيبا بماء فعادا بعد أبوالا
ويحتمل جوابا ثالثا وهو أن يكون قولهم لشعيب ذلك من تعنتهم وبهتانهم وادعائهم أن شعيبا كان على ملتهم لا كما قال فرعون لموسى. وقوله: {وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا} كناية عن أتباعه لمجرد فائدتهم وأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن قال ذلك عن نفسه وأتباعه فقد استثنى والمعلق بالمشيئة لايلزم إمكانه شرعا تقديرا والاعتراف بالقدرة والرجوع لعلمه سبحانه وأن علم العبد عصمة نفسه أدبا مع ربه لاشكا.
ويجوز أن يراد بالعود في ملتهم مجرد المساكنة والاختلاط بدليل قوله: {إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا}. ونظيره: {وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} ويكون ذلك إشارة إلى الهجرة عنهم وترك الإجابة لهم لا جوابا لهم. وفيه بعد.
السادس: تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس مغموز فيما بينهم بأن يطلق اسم الجنس على الجميع.
كقوله: {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلاَّ إِبْلِيسَ} وأنه عد منهم مع أنه كان من الجن تغليبا لكونه جنيا واحدا فيما بينهم ولأن حمل الاستثناء على الاتصال هو الأصل. ويدل على كونه من غير الملائكة ما رواه مسلم في صحيحه: " خلقت الملائكة من نور والجن من النار ".
وقيل: إنه كان ملكا فسلب الملكية وأجيب عن كونه من الجن بأنه اسم لنوع من الملائكة.
قال الزمخشري: كان مختلطا بهم فحينئذ عمته الدعوة بالخلطة لا بالجنس فيكون من تغليب الأكثر.
هذا إن جعلنا الاستثناء متصلا ولم يجعل [إلا] بمعنى [لكن].
وقال ابن جنى في [ القد ]: قال أبو الحسن في قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى.
ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ} وإنما المتخذ عيسى دون أمه فهو من باب:
*لنا قمراها والنجوم الطوالع*
السابع: تغليب الموجود على ما لم يوجد.
كقوله: {بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} قال الزمخشري: فإن المراد: المنزل كله وإنما عبر عنه بلفظ المضى وإن كان بعضه مترقبا تغليبا للموجود على ما لم يوجد.
الثامن: تغليب الإسلام.
كقوله تعالى: {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ} قاله الزمخشري: لأن الدرجات للعلو والدركات للسفل فاستعمل الدرجات في القسمين تغليبا.
التاسع: تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه.
كقوله تعالى: {ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ} ذكر الأيدي لأن أكثر الأعمال.
نزاول بها فحصل الجمع بالواقع بالأيدي تغليبا أشار إليه الزمخشري في آخر آل عمران.
ويشاكله ما أنشده الغزنوي في "العامريات" لصفية بنت عبد المطلب:
فلا والعاديات غداة جمع
بأيديها إذا سطع الغبار
العاشر: تغليب الأشهر.
كقوله تعالى: {يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ} أراد المشرق والمغرب فغلب المشرق لأنه أشهر الجهتين قاله ابن الشجري وسيأتي فيه وجه آخر.
فائدتان:.
أحداهما: جميع باب التغليب من المجاز لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له ألا ترى أن القانتين موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف فإطلاقه على الذكور والإناث على غير ما وضع له وقس على هذا جميع الأمثلة السابقة.
الثانية: الغالب من التغليب أن يراعى الأشرف كما سبق ولهذا قالوا في تثنية الأب والأم: أبوان وفي تثنية المشرق والمغرب: المشرقان لأن الشرق دال على الوجود والغرب دال على العدم والوجود لا محالة أشرف وكذلك القمران، قال:
*لنا قمراها والنجوم الطوالع*
أراد الشمس والقمر فغلب القمر لشرف التذكير وأما قولهم سنة العمرين، يريدون.
أبا بكر وعمر قال ابن سيده في "المحكم": إنما فعلوا ذلك إيثارا للخفة أي غلب الأخف على الأثقل لأن لفظ [عمر] مفرد ولفظ أبي بكر مركب.
وذكر أبو عبيدة في غريب الحديث أن ذلك للشهرة وطول المدة.
وذكر غيرهما أن المراد به عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وعلى هذا فلا تغليب.
ورد بأنهم نطقوا بالعمرين قبل أن يعرفوا عمر بن عبد العزيز فقالوا يوم الجمل لعلي بن أبي طالب: سنة العمرين.
الالتفات .
وفيه مباحث:.
الأول: في حقيقة .
وهو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطرية واستدرارا للسامع وتجديدا لنشاطه وصيانة لخاطره من الملال والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه كما قيل:
لا يصلح النفس إن كانت مصرفة ... إلا التنقل من حال إلى حال
قال حازم في "منهاج البلغاء": وهم يسأمون الاستمرار على ضمير متكلم أو ضمير مخاطب فينتقلون من الخطاب إلى الغيبة وكذلك ايضا يتلاعب المتكلم بضميره فتارة يجعله تاء على جهة الإخبار عن نفسه وتارة يجعله كافا فيجعل نفسه مخاطبا وتارة يجعله هاء فيقيم نفسه مقام الغائب. فلذلك كان الكلام المتوالي فيه ضمير المتكلم والمخاطب لا يستطاب وإنما يحسن الانتقال من بعضها إلى بعض وهو نقل معنوي لا لفظي وشرطه أن يكون الضمير في المتنقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى الملتف عنه ليخرج نحو أكرم زيدا وأحسن إليه فضمير أنت الذي هو في أكرم غير الضمير في إليه.
واعلم أن للمتكلم والخطاب والغيبة مقامات والمشهور أن الالتفات هو الانتقال من أحدها إلى الآخر بعد التعبير بالأول.
وقال السكاكي: إما ذلك وإما التعبير بأحدهما فيما حقه التعبير بغيره.
البحث الثاني في أقسامه.
وهي كثيرة:.
الأول: الالتفات من التكلم إلى الخطاب .
ووجهه حث السامع وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه وأنه أعطاه فضل عنايةوتخصيص بالمواجهة كقوله تعالى: {وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} ، الأصل: "وإليه أرجع" فالتفت من التكلم إلى الخطاب وفائدته أنه أخرج الكلام في معرض مناصحته لنفسه وهو يريد نصح قومه تلطفا وإعلاما أنه يريده لنفسه ثم التفت إليهم لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله.
وأيضا فإن قومه لما أنكروا عليه عبادته لله أخرج الكلام معهم بحسب حالهم فاحتج عليهم بأنه يقبح منه أنه لا يعبد فاطره ومبدعه ثم حذرهم بقوله: {وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}.
لذا جعلوه من الالتفات وفيه نظر لأنه إنما يكون منه إذا كان القصد الإخبار عن نفسه في كلتا الجملتين وهاهنا ليس كذلك لجواز أن يكون أراد بقوله: {وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} الخاطبين ولم يرد نفسه ويؤيده ضمير الجمع ولو أراد نفسه لقال:[ نرجع].
وأيضا فشرط الالتفات أن يكون في جملتين و[ فطرني ] [ وإليه ترجعون ] كلام واحد.
وأجيب بأنه لو كان المراد بقوله:[ ترجعون ] ظاهره لما صح الاستفهام الإنكاري، لأن رجوع العبد إلى مولاه ليس بمعنى أن يعبده غير ذلك الراجع فالمعنى: كيف أعبد من إليه رجوعي وإنما ترك [ وإليه أرجع ]إلى [ وإليه ترجعون ] لأنه داخل فيهم.
ومع ذلك أفاد فائدة حسنة وهي أنه نبههم أنهم مثله في وجوب عبادة من إليه الرجوع فعلى هذا الواو للحال وعلى الأول واو العطف.
ومنه قوله: {رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ} عدل عن قوله: {رَحْمَةً مِنَّا} إلى قوله: {رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ} لما فيه من الإشعار بأن ربوبيته تقتضي رحمته وأنه رحيم بعبده كقوله: {كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ}.
وقوله: {ادْعُوا رَبَّكُمْ} {وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ} وهو كثير.
وقوله: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ} ولم يقل:[ لنغفر لك ] تعليقا لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن لسائر أسمائه الحسنى ولهذا علق به النصر فقال: {وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً}.
الثاني: من التكلم إلى الغيبة.
ووجهه أن يفهم السامع أن هذا نمط المتكلم وقصده من السامع حضر أو غاب،.
وأنه في كلامه ليس ممن يتلون ويتوجه فيكون في المضمر ونحوه ذا لونين وأراد بالانتقال إلى الغيبة الإبقاء على المخاطب من قرعه في الوجه بسهام الهجر فالغيبة أروح له وأبقى على ماء وجهه أن يفوت كقوله: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ} حيث لم يقل: [ لنا ] تحريضا على فعل الصلاة لحق الربوبية.
وقوله: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}.
وقوله: {يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً} إلى قوله: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} ولم يقل:[ بي ].و.
له فائدتان:.
إحداهما: دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لها، والثاني : تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات المذكورة من النبوة والأمية التي هي أكبر دليل على صدقه وأنه لا يستحق الاتباع لذاته بل لهذه الخصائص.
الثالث: من الخطاب إلى التكلم.
كقوله: {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا}، وهذا إنما يتمشى على قول من لم يشترط أن يكون المراد بالالتفات واحدا فأما من اشترطه فلا يحسن أن يمثل به ويمكن أن يمثل بقوله تعالى: {قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ} على أنه سبحانه نزل نفسه منزلة المخاطب.
الرابع: من الخطاب إلى الغيبة .
كقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ} فقد التفت عن {كُنْتُمْ} إلى {جَرَيْنَ بِهِمْ} وفائدة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم لتعجبه من فعلهم وكفرهم إذ لو استمر علىخطابهم لفاتت تلك الفائدة.
وقيل: لأن الخطاب أولا كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم بدليل قوله: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} فلو قال:[ وجرين بكم ] للزم الذم للجميع فالتفت عن الأول للإشارة إلى الاختصاص بهؤلاء الذين شأنهم ما ذكره عنهم في آخر الآية فعدل عن الخطاب العام إلى الذم الخاص ببعضهم وهم الموصوفون بما أخبر به عنهم.
وقيل: لأنهم وقت الركوب حصروا لأنهم خافوا الهلاك وتقلب الرياح فناداهم نداء الحاضرين ثم أن الرياح لما جرت بما تشتهي النفوس وأمنت الهلاك لم يبق حضورهم كما كان على ما هي عادة الإنسان أنه إذا أمن غاب فلما غابوا عند جريه بريح طيبة فكرهم الله بصيغة الغيبة فقال :{وَجَرَيْنَ بِهِمْ}.
وقوله: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ} ثم قال: {يُطَافُ عَلَيْهِمْ} فانتقل عن الخطاب إلى الغيبة ولو ربط بما قبله لقال:" يطاف عليكم" لأنه مخاطب لا مخبر ثم التفت فقال: {وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} فكرر الالتفات.
وقوله: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ}.
وقوله: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ}.
وقوله: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ} والأصل [فقطعتم] عطفا على ما قبله لكن عدل من الخطاب إلى الغيبة فقيل إنه سبحانه نعى عليهم ما أفسدوه من أمر دينهم إلى قوم آخرين ووبخهم عليه قائلا: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله لم !.
وجعل منه ابن الشجري: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} وقد سبق أنه على حذف المفعول فلا التفات.
الخامس: من الغيبة إلى التكلم.
كقوله: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ}.
{وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا}.
{وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً}.
وقوله: {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ} وفائدته أنه لما كان.
سوق السحاب إلى البلد إحياء للأرض بعد موتها بالمطر دالا على القدرة الباهرة والآية العظيمة التي لا يقدر عليها غيره عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم لأنه أدخل في الاختصاص وأدل عليه وأفخم.
وفيه معنى آخر وهو أن الأقوال المذكورة في هذه الآية منها ما أخبر به سبحانه بسببه وهو سوق السحاب فإنه يسوق الرياح فتسوقه الملائكة بأمره وإحياء الأرض به بواسطة إنزاله وسائر الأسباب التي يقتضيها حكمه وعلمه. وعادته سبحانه في كل هذه الأفعال أن يخبر بها بنون التعظيم الدالة على أن له جندا وخلقا قد سخرهم في ذلك كقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} أي إذا قرأه رسولنا جبريل. وقوله: {يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً}.
وأما إرسال السحاب فهو سحاب يأذن في إرسالها ولم يذكر له سببا بخلاف سوق السحاب وإنزال المطر فإنه قد ذكر أسبابه: {أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا} {أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ}.
وجعل الزمخشري منه قوله: في سورة طه: {وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى}: وزعم الجرجاني أن في هذه الآية التفاتا وجعل قوله: { وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً} آخر كلام موسى ثم ابتدأ الله تعالى فأخبر عن نفسه بأوصافه لمعالجتها.
وأشار الزمخشري إلى أن فائدة الالتفات إلى التكلم في هذه المواضع التنبيه على.
التخصيص بالقدرة وأنه لا يدخل تحت قدرة واحد وهو معنى قول غيره إن الإشارة إلى حكاية الحال واستحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة. وكذا يفعلون لكل فعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو تهم المخاطب وإنما قال: {فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً} لإفادة بقاء المطر زمانا بعد زمان.
ومثله: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ} ، عدل عن الغيبة في[ قضاهن ] و[ سواهن ] إلى التكلم في قوله: {وَزَيَّنَّا}، فقيل للاهتمام بذلك والإخبار عن نفسه بأنه جعل الكوكب زينة السماء الدنيا وحفظا تكذيبا لمن أنكر ذلك.
وقيل: لما كانت الأفعال المذكورة في هذه الآية نوعين:.
أحدهما : وجه الإخبار عنه بوقوعه في الأيام المذكورة وهو خلق الأرض في يومين وجعل الرواسي من فوقها وإلقاء البركة فيها وتقدير الأقوات في تمام أربعة أيام ثم الإخبار بأنه استوى إلى السماء وأنه أتمها وأكملها سبعا في يومين فأتى في هذا النوع بضمير الغائب عطفا على أول الكلام في قوله: {قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ} إلى قوله: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} الآية.
والثاني: قصد به الإخبار مطلقا من غير قصد مدة خلقه وهو تزيين سماء الدنيا بمصابيح وجعلها حفظا فإنه لم يقصد بيان مدة ذلك بخلاف ما قبله فإن نوع الأول يتضمن إيجادا لهذه المخلوقات العظيمة في هذه المدة اليسيرة وذلك من أعظم آثار قدرته. وأما تزيين.
السماء الدنيا بالمصابيح فليس المقصود به الإخبار عن مدة خلق النجوم فالتفت من الغيبة إلى التكلم فقال: {زَيَّنَّا}.
فائدة في تكرار الالتفات في موضع واحد
وقد تكرر الالتفات في قوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} في أربعة مواضع، فانتقل عن الغيبة في قوله: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ}، إلى التكلم في قوله: {بَارَكْنَا حَوْلَهُ} ثم عن التكلم إلى الغيبة في قوله:{ليريه} بالياء على قراءة الحسن ثم عن الغيبة إلى التكلم في قوله: {آياتنا} ثم عن التكلم إلى الغيبة في قوله: {إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}.
وكذلك في الفاتحة فإن من أولها إلى قوله: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} أسلوب غيبة ثم التفت بقوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} إلى أسلوب خطاب في قوله: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} ثم التفت إلى الغيبة بقوله: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} ولم يقل[ الذين غضبت ] كما قال: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}.
السادس: من الغيبة إلى الخطاب.
كقوله: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً} ولم يقل:.
[ لقد جاءوا ] للدلالة على أن من قال مثل قولهم ينبغي أن يكون موبخا علهي منكرا عليه قوله كأنه يخاطب به قوما حاضرين.
وقوله: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ} ثم قال: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا}.
وقوله: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً}.
وقوله: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ}.
وقوله: {فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ}.
وقوله: {ألم تر إلى ربك كيف مد الظل} ثم قال: {ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً}.
وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ } الآية.
وقوله: {وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى}.
وقوله: {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}.
وقوله: {أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ}.
وقوله حكاية عن الخليل: {وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ.
تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً} إلى قوله: {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ}.
وقوله: {إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً}.
وقوله: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا} إلى قوله: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ}.
وقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ..} الآية.
وجعل بعضهم منه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا} ، وهو عجيب لأن [الذين] موصول لفظه للغيبة ولا بد له من عائد وهو الضمير في [آمنوا] فكيف يعود ضمير مخاطب على غائب ! فهذا مما لا يعقل.
وقوله: { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ} ، فقد التفت عن الغيبة وهو [مالك] إلى الخطاب وهو [إياك نعبد].
ولك أن تقول: إن كان التقدير: قولوا الحمد لله ففيه التفاتان - أعنى في الكلام المأمور به:.
أحدهما : في لفظ الجلالة فإن الله تعالى حاضر فأصله الحمد لك.
والثاني:[ إياك ] لمجيئه على خلاف الاسلوب السابق وإن لم يقدر: [قولوا] كان في [الحمد لله] التفات عن التكلم إلى الغيبة فإن الله سبحانه حمد نفسه ولا يكون في { إياك
نعبد} التفات لأن [قولوا] مقدرة معها قطعا فإما أن يكون في الآية التفات أو لا التفات بالكلية.
السابع: بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه.
فيكون التفاتا عنه كقوله تعالى: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} بعد { أَنْعَمْتَ} فإن المعنى: غير الذين غضبت عليهم. ذكره التنوخي في "الأقصى القريب" والخفاجي وابن الأثير وغيرهم.
واعلم أنه على رأى السكاكي تجيء الأقسام الستة في القسم الاخير وهو الانتقال التقديري.
وزعم صحاب "ضوء المصباح" أنه لم يستعمل منها إلا وضع الخطاب والغيبة موضع التكلم ووضع التكلم موضع الخطاب ومثل الثالث بقوله: {وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي}، مكان [ وما لكم لا تعبدون الذي فطركم ].
وجعل بعضهم من الالتفات قوله تعالى: {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ} ثم قال: {وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ}، وقوله: {الْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ}.
البحث الثالث: في أسبابه.
اعلم أن للالتفات فوائد عامة وخاصة فمن العامة التفنن والانتقال من أسلوب إلى آخر.
لما في ذلك من تنشيط السامع واستجلاب صفائه واتساع مجاري الكلام وتسهيل لوزن والقافية.
وقال البيانيون: إن الكلام إذا جاء على أسلوب واحد وطال حسن تغيير الطريقة.
ونازعهم القاضي شمس الدين بن الجوزي وقال: الظاهر أن مجرد هذا لا يكفي في المناسبة فإنا رأينا كلاما أطول في هذا والأسلوب محفوظ قال تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ..} إلى أن ذكر عشرة أصناف وختم بـ {الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ}، ولم يغير الأسلوب وإنما المناسبة أن الإنسان كثير التقلب وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن ويقلبه كيف يشاء فإنه يكون غائبا فيحضر بكلمة واحدة وآخر يكون حاضرا فيغيب فالله تعالى لما قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} تنبه السامع وحضر قلبه فقال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}.
وأما الخاصة فتختلف باختلاف محاله ومواقع الكلام فيه على ما يقصده المتكلم.
فمنها: قصد تعظيم شأن المخاطب، كما في: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، فإن العبد إذا افتتح حمد مولاه بقوله: [الحمد لله] الدال على اختصاصه بالحمد وجد من نفسه التحرك للإقبال عليه سبحانه فإذا انتقل إلى قوله: {رَبِّ الْعَالَمِينَ} الدال على ربوبيته لجميعهم قوى تحركه فإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الدال على أنه منعم بأنواع النعم جليلها وحقيرها تزايد التحرك عنده فإذا وصل لـ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} وهو خاتمة الصافات الدالة على أنه مالك الأمر يوم الجزاء فيتأهب قربه وتيقن الإقبال عليه بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات.
وقيل: إنما اختير للحمد لفظ الغيبة وللعبادة الخطاب للإشارة إلى أن الحمد دون العبادة في الرتبة فإنك تحمد نظيرك ولا تعبده إذ الإنسان يحمد من لا يعبده ولا يعبد من لا يحمده فلما كان كذلك استعمل لفظ الحمد لتوسطه مع الغيبة في الخبر فقال:[ الحمد لله ] ولم يقل:[ الحمد لك ] ولفظ العبادة مع الخطاب فقال: { إياك نعبد } لينسب إلى العظيم حال المخاطبة والمواجهة على ما هو أعلى رتبة وذلك على طريق التأدب. وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة فقال: {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} مصرحا بذكر المنعم وإسناد الإنعام إليه لفظا ولم يقل:[ صراط المنعم علهيم ] فلما صار إلى ذكر الغضب روى عنه لفظ الغضب في النسبة إليه لفظا وجاء باللفظ متحرفا عن ذكر الغاضب فلم يقل غير الذين غضبت عليهم تفاديا عن نسبة الغضب في اللفظ حال المواجهة.
ومن هذا قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً}، فإن التأدب في الغيبة دون الخطاب.
وقيل: لأنه لما ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه بالصفات العظيمة من كونه ربا للعالمين ورحمانا ورحيما ومالكا ليوم الدين تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بأن يكون معبودا دون غيره مستعانا به فخوطب بذلك لتميزه بالصفات المذكورة تعظيما لشأنه كله حتى كأنه قيل إياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة لا غيرك.
قيل: ومن لطائف التنبيه على أن مبتدأ الخلق الغيبة منهم عنه سبحانه وقصورهم عن محاضرته ومخاطبته وقيام حجاب العظمة عليهم فإذا عرفوه بما هو له وتوسلوا للقرب بالثناء عليه وأقروا بالمحامد له وتعبدوا له بما يليق بهم تأهلوا لمخاطباته ومناجاته فقالوا: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}.
وفيه أنهم يبدون بين يدي كل دعاء له سبحانه ومناجاة له صفات عظمته لمخاطبته على الأدب والتعظيم لا عن الغفلة والإغفال ولا عن اللعب والاستخفاف كما يدعو بلا نية أو على تلعب وغفلة وهم كثير.
ومنه أن مناجاته لا تصعد إلا إذا تطهر من أدناس الجهالة به كما لا تسجد الإعضاء إلا بعد التطهير من حدث الأجسام ولذلك قدمت الاستعاذة على القرآن.
قال الزمخشري: وكما في قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ} ولم يقل:" واستغفرت لهم " [وعدل عنه إلى طريق الالتفات] لأن في هذا الالتفات بيان تعظيم استغفاره وأن شفاعة من اسمه الرسول بمكان.
ومنها: التنبيه على ما حق الكلام أن يكون واردا عليه، كقوله تعالى: {وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}، أصل الكلام:[ وما لكم لا تعبدون الذي فطركم ] ولكنه أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه وهو يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويريهم أنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه ثم لما انقضى غرضه من ذلك قال: {وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} ليدل على ما كان من أصل الكلام ومقتضيا له ثم ساقه هذا المساق إلى أن قال :{إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ}.
ومنها : أن يكون الغرض به التتميم لمعنى مقصود للمتكلم، فيأتي به محافظة على تتميم.
ما قصد إليه من المعنى المطلوب له، كقوله: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} ، أصل الكلام:[ إنا مرسلين رحمة منا ] ولكنه وضع الظاهر موضع المضمر للإنذار بأن الربوبية تقتضي الرحمة للمربوبين للقدرة عليهم أو لتخصيص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالذكر أو الإشارة إلى أن الكتاب إنما هو إليه دون غيره ثم التفت بإعادة الضمير إلى الرب الموضوع موضع المضمر للمعنى المقصود من تتميم المعنى.
ومنها: قصد المبالغة، كقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ} كأنه يذكرلغيرهم حالهم ليتعجب منها ويستدعي منه الإنكار والتقبيح لها إشارة منه على سبيل المبالغة إلى أن ما يعتمدونه بعد الإنجاء من البغي في الأرض بغير الحق مما ينكر ويقبح.
ومنها: قصد الدلالة على الاختصاص، كقوله: {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ } فإنه لما كان سوق السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض بعد موتها بالمطر دالا على القدرة الباهرة التي لا يقدر عليها غيره عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم لأنه أدخل في الاختصاص وأدل عليه: [ سقنا ] و[ أحيينا ].
ومنها: قصد الاهتمام، كقوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} فعدل عن الغيبة في[ قضاهن ] و[ أوحى ] إلى التكلم في [ وزينا السماء الدنيا ] للاهتمام بالإخبار عن نفسه فإنه تعالى جعل الكواكب في سماء الدنيا للزينة والحفظ وذلك لأن طائفة اعتقدت في النجوم أنها ليست في سماء الدنيا وأنها ليست حفظا ولا رجوما فعدل إلى التكلم والإخبار عن ذلك لكونه مهما من مهمات الاعتقاد ولتكذيب الفرقة المعتقدة بطلانه.
ومنها: قصد التوبيخ، كقوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً}، عدل عن الغيبة إلى الخطاب للدلالة على أن قائل مثل قولهم ينبغي أن يكون موبخا ومنكرا عليه ولما اراد توبيخهم على هذا أخبر عنه بالحضور، فقال: {لَقَدْ جِئْتُمْ} لأن توبيخ الحاضر ابلغ في الإهانة له.
ومنه قوله تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ}، قال: {تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ} دون [تقطعتم أمركم بينكم]، كأنه ينعى عليهم ما أفسدوه من أمر دينهم إلى قوم آخرين ويقبح عندهم ما فعلوه ويوبخهم عليه قائلا ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله فجعلوا أمر دينهم به قطعا تمثيلا لأخلاقهم في الدين.
فائدة.
اختلف في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ} بعد {رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ}.
فقيل: إن الكلام تم عند قوله: {لا رَيْبَ فِيهِ} وهذا الذي بعده من مقولا لله تصديقا لهم.
وقيل: بل هو من بقية كلامهم الأول على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ}.
فإن قلت: قد قال في آخر السورة: {وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ}، فلم عدل عن الخطاب هنا قلت إنما جاء الالتفات في صدر السورة لأن المقام يقتضيه فإن الإلهية تقتضي الخير والشر لتنصف المظلومين من الظالمين فكان العدول إلى ذكر الاسم الأعظم أولى. وأما قوله تعالى في آخر السورة: {إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ}، فذلك المقام مقام الطلب للعبد من ربه أن ينعم عليه بفضله وأن يتجاوز عن سيئاته فلم يكن فيه ما يقتضى العدول عن الأصل المستمر.
البحث الرابع: في شرطه.
تقدم أن شرط الالتفات أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى المنتقل عنه وشرطه أيضا أن يكون في جملتين أي كلامين مستقلين حتى يمتنع بين الشرط وجوابه.
وفي هذا الشرط نظره فقد وقع في القرآن مواضع الالتفات فيها وقع في كلام واحد وإن لم يكن بين جزأى الجملة، كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي}.
وقوله: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا}.
وقوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}، بعد قوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ} التقدير إن وهبت أمرأة نفسها للنبي إنا أحللنا لك وجملتا الشرط والجزاء كلام واحد.
وقوله: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ}.
وقوله: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} وفيه التفاتان: أحدهما بين [ أرسلنا ] والجلالة، والثاني بين الكاف في[ أرسلناك ] [ ورسوله ] وكل منهما في كلام واحد.
وقوله: {سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ}.
وقوله: {فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً}، وجوز الزمخشري فيه أن يكون ضمير [ جزاؤكم ] يعود على[ التابعين ] على طريق الالتفات.
وقوله: {وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ}، على قراءة الياء.
وقوله: {وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً}، قال التنوخي في" الأقصى القريب ": الواو للحال.
وقوله: {وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}.
البحث الخامس: أنه يقرب من الالتفات نقل الكلام إلى غيره.
وإنما يفعل ذلك إذا ابتلي العاقل بخصم جاهل متعصب فيجب أن يقطع الكلام معه في تلك المسألة لأنه كلما كان خوضه معه أكثر كان بعده عن القبول أشد فالوجه حينئذ أن يقطع الكلام معه في تلك المسألة وأن يؤخذ في كلام آخر أجنبي ويطنب فيه بحيث ينسى الأول فإذا اشتغل خاطره به أدرج له أثناء الكلام الأجنبي مقدمة تناسب ذلك المطلب الأول ليتمكن من انقياده.
وهذا ذكره الإمام أبو الفضل في كتاب" درة التنزيل"، وجعل منه قوله تعالى: {اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ}، قال: إن قوله: [ واذكر ] ليس متصلا بما قبله بل نقلا لهم عما هم عليه والمقدمة المدرجة قوله: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً} إلى قوله: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ}.
وهذا الذي قاله يخرج الآية عن الاتصال مع أن في الاتصال وجوها مذكورة في موضعها.
وألحق به الأستاذ أبو جعفر بن الزبير قوله تعالى: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا..} الآية، فهذا إنكار منهم للبعث واستبعاد نحو الوارد في سورة ص، فأعقب ذلك بما يشبه الالتفات بقوله: {أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا..} إلى قوله: {وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ}، فبعد العدول عن مجاوبتهم في قولهم: {ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ} وذكر اختلافهم المسبب عن تكذيبهم في قوله: {بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ}، صرف تعالى الكلام إلى نبيه والمؤمنين فقال: {أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا..} إلى قوله: {وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً} وذلك حكمة تدرك مشاهدة لا يمكنهم التوقف في شيء منه ولا حفظ عنهم إنكاره فعند تكرر هذا قال تعالى: {كَذَلِكَ الْخُرُوجُ}.
ومما يقرب من الالتفات أيضا الانتقال من خطاب الواحد والاثنين والجمع إلى خطاب آخر وهو ستة أقسام كما سبق تقسيم الالتفات:.
أحدها: الانتقال من خطاب الواحد لخطاب الاثنين، كقوله تعالى: {جِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الأَرْضِ}.
الثاني: من خطاب الواحد إلىخطاب الجمع: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}.
الثالث: من الاثنين إلى الواحد، كقوله: {فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى}،{فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى}.
الرابع: من الاثنين إلى الجمع، كقوله: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}، وفيه انتقال آخر من الجمع إلى الواحد فإنه ثنى ثم جمع ثم وحد توسعا في الكلام.
وحكمة التثنية أن موسى وهارون هما اللذان يقرران قواعد النبوة ويحكمان في الشريعة فخصهما بذلك ثم خاطب الجميع باتخاذ البيوت قبلة للعبادة لأن الجميع مأمورون بها ثم قال لموسى وحده:{وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} لأنه الرسول الحقيقي الذي إليه البشارة والإنذار.
الخامس: من الجمع إلى الواحد، كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} وقد سبق حكمته. ومن نظائره قول بعضهم في قوله تعالى: {قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً } ثم قال: {إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً} ، ولم يقل [منا] مع أنه للجمع أو للواحد المعظم نفسه وحكمته المناسبة للواقع فالهدى لا يكون إلا من الله فناسب الخاص للخاص.
السادس : من الجمع إلى التثنية، كقوله: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا} إلى قوله: {فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}.
السابع: ذكر بعضهم من الالتفات تعقيب الكلام بجملة مستقلة ملاقية له في المعنى على طريق المثل أو الدعاء، فالأول كقوله: {وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً} والثاني كقوله: {ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ}.
الثامن: من الماضي إلى الأمر، كقوله: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ} وقوله: {وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} التاسع: من المستقبل إلى الأمر، تعظيما لحال من أجرى عليه المستقبل. وبالضد من ذلك في حق من أجرى عليه الأمر، كقوله تعالى: {يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ} إلى قوله: {بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ} فإنه أنما قال: {أُشْهِدُ اللَّهَ} ،و {اشْهَدُوا} ولم يقل [ وأشهدكم ] ليكون موازنا له ولا شك أن معنى إشهاد الله على البراءة صحيح في معنى يثبت التوحيد بخلاف إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم ودلالة على قلة المبالاة به فلذلك عدل عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهما وجىء به على لفظ الأمر كما تقول للرجل منكرا أشهد على أني أحبك.
العاشر: من الماضي إلى المستقبل، نحو: {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ}،{فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ}،{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}.
والحكمة في هذه أن الكفر لما كان من شأنه إذا حصل أن يستمر حكمه عبر عنه بالماضي ليفيد ذلك مع كونه نافيا أنه قد مضى عليه زمان ولا كذلك الصد عن سبيل الله فإن حكمه إنما ثبت حال حصوله مع أن في الفعل المستقبل إشعارا بالتكثير،.
فيشعر قوله: {وَيَصُدُّونَ} أنه في كل وقت بصدد ذلك ولو قال وصدوا لأشعر بانقطاع صدهم.
الحادي عشر: عكسه، كقوله: {يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ}،{وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ}.
قالوا: والفائدة في الفعل الماضي إذا أخبر به عن المستقبل الذي لم يوجد أنه أبلغ وأعظم موقعا لتنزيله منزلة الواقع والفائدة في المستقبل إذا أخبر به عن الماضي لتتبين هيئة الفعل باستحضار صورته ليكون السامع كأنه شاهد وإنما عبر في الأمر بالتوبيخ بالماضي بعد قوله: [ ينفخ ] للإشعار بتحقيق الوقوع وثبوته وأنه كائن لا محالة كقوله: {وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً} والمعنى: يبرزون، وإنما قال: [ وحشرناهم ] بعد [نسير ] [ وترى ] وهما مستقبلان لذلك.
التضمين.
وهو إعطاء الشيء معنى الشيء وتارة يكون في الاسماء وفي الأفعال وفي الحروف فأما في الأسماء فهو أن تضمن اسما معنى اسم لإفادة معنى الاسمين جميعا كقوله تعالى: {حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ} ضمن حقيق معنى حريص ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه.
وأما الأفعال فأن تضمن فعلا معنى فعل آخر ويكون فيه معنى الفعلين جميعا وذلك بأن يكون الفعل يتعدى بحرف فيأتي متعديا بحرف آخر ليس من عادته التعدي به فيحتاج إما إلى تأويله أو تأويل الفعل ليصح تعديه به.
واختلفوا أيهما أولى فذهب أهل اللغة وجماعة من النحويين إلى أن التوسع في الحرف وأنه واقع موقع غيره من الحروف أولى.
وذهب المحققون إلى أن التوسع في الفعل وتعديته بما لا يتعدى لتضمنه معنى ما يتعدى بذلك الحرف أولى لأن التوسع في الأفعال أكثر.
مثاله قوله تعالى: {عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} فضمن [ يشرب ] معنى [ يروي ] لأنه لا يتعدى بالباء فلذلك دخلت الباء وإلا فـ[يشرب] يتعدى بنفسه فأريد باللفظ الشرب والري معا فجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد.
وقيل التجوز في الحرف وهو الباء فإنها بمعنى [من].
وقيل لا مجاز أصلا بل العين هاهنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء،.
لا إلى الماء نفسه نحو نزلت بعين فصار كقوله: مكانا يشرب به.
وعلى هذا: {فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ}، قاله الراغب.
وهذا بخلاف المجاز فإن فيه العدول عن مسماه بالكلية ويراد به غيره كقوله: {جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} ، فإنه استعمل [ أراد ] في معنى مقاربة السقوط لأنه من لوازم الإرادة وإن من أراد شيئا فقد قارب فعلهولم يرد باللفظ هذا المعنى الحقيقي الذي هو الإرادة البتة. والتضمين أيضا مجاز لأن اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز معا والجمع بينهما مجاز خاص يسمونه بالتضمين تفرقه بينه وبين المجاز المطلق.
ومن التضمين قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} لأنه لا يقال: رفثت إلى المرأة لكن لما كان بمعنى الإفضاء ساغ ذلك.
وهكذا قوله: {هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى} وإنما يقال: هل لك في كذا ؟ لكن المعنى أدعوك إلى أن تزكى.
وقوله: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ}، فجاء بـ[من] لأنه ضمن التوبة معنى العفو والصفح.
وقوله : {إِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ} ، وإنما يقال: خلوت به لكن ضمن [ خلوا ] معنى [ ذهبوا ] [ وانصرفوا ] وهو معادل لقوله لقوا وهذا أولى من قول من قال: إن [ إلى ] هنا بمعنى [الباء] أو بمعنى [مع].
وقال مكي: إنما لم تأت الباء لأنه يقال خلوت به إذا سخرت منه فأتى بـ[إلى] لدفع هذا الوهم.
وقوله: {لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ}، قيل: الصراط منصوب على المفعول به أي لألزمن لك صراطك أو لأملكنه لهم و[ أقعد ] وإن كان غير متعد ضمن معنى فعل متعد.
وقوله: {وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ}، ضمن [تعد] معنى [تنصرف] فعدى بـ[من] قال ابن الشجري: ومن زعم أنه كان حق الكلام " لا تعد عينيك عنهم " بالنصب لأن تعد متعد بنفسه فباطل لأن عدوت وجاوزت بمعنى واحد. وأنت لا تقول: جاوز فلان عينه عن فلان ولو كانت التلاوة بنصب العين لكان اللفظ يتضمنها محمولا ايضا على لا تصرف عينك عنهم وإذا كذلك فالذي وردت به التلاوة من رفع العين يئول إلى معنى النصب فيها إذ كان [لا تعد عيناك] بمنزلة [لا تنصرف] ومعناه لا تصرف عينك عنهم فالفعل مسند إلى العين وهو في الحقيقة موجه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قال: {وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ} اسند الإعجاب إلى الأموال والمعنى لا تعجب بأموالهم.
وقوله: {أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا}، ضمن معنى [ لتدخلن ] أو [ لتصيرن ] أما قول شعيب: {وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا} فليس اعترافا بأنه كان فيهم بل مؤول على ما سبق وتأويل آخر وهو أن يكون من نسبة فعل البعض إلى الجماعة أو قال على طريق المشاكلة لكلامهم وهذا أحسن.
وقوله: {أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً} ضمن [ لا تشرك ] معنى [ لا تعدل ] والعدل: التسوية أي لا تسوى به شيئا.
وقوله: {وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ} ضمن معنى [ أنابوا ] فعدى بحرفه.
وقوله: {إِِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا} ضمن {لَتُبْدِي بِهِ} معنى [ تخبر به ] أو [ لتعلم ] ليفيد الإظهار معنى الإخبار لأن الخبر قد يقع سرا غير ظاهر.
وقوله: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} جوز الزمخشري نصب {مَقَاماً} على الظرف على تضمين {يَبْعَثَكَ} معنى يقيمك.
وقوله: {فأجمعوا أمركم وشركاءكم}، قال الفارسي: ومن قرأ { فَأَجْمِعُوا } بالقطع أراد فاجمعوا أمركم وشركاءكم كقوله:
*متقلدا سيفا ورمحا*
وقوله: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ}، قال ابن سيده: عداه بـ[من] لأنه في معنى كشف الفزع.
وقوله: {أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ}، فإنه يقال ذل له لا عليه ولكنه هنا ضمن معنى التعطف والتحنن.
وقوله: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ضمن {يُؤْلُونَ} معنى [ يمتعنون ] من وطئهن بالآلية.
وقوله: {لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلأِ الأَعْلَى} أي لا يصغون.
{إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ} أي أنزل.
{فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} أي أحل له.
{وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} أي مميزك.
{إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} أي لا يرضى.
{اسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ} أي أنيبوا إليه وارجعوا.
{هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ} أي زال.
{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} فإنه يقال: خالفت زيدا من غير احتياج لتعديه بالجار وإنما جاء محمولا على [ ينحرفون ] أو[ يزيغون ].
ومثله تعدية [رحيم] بالباء في نحو: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً} حملا على [رءوف] في نحو: {رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} ألا ترى أنك تقول: رأفت به ولا تقول رحمت به ولكن لما وافقه في المعنى تنزل منزلته في التعدية.
وقوله: {إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} ضمن معنى سائل.
{الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ} قال الزمخشري: ضمن معنى [ تحاملوا ] فعداه بـ[على] والأصل فيه من.
تنبيهان:.
الأول: الأكثر أن يراعى في التعدية ما ضمن منه وهو المحذوف لا المذكور كقوله تعالى: {الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} أي الإفضاء.
وقوله: {عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} أي يروى بها وغيره مما سبق.
ولم أجد مراعاة الملفوظ به إلا في موضعين: أحدهما قوله تعالى: {يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ} على قول ابن الضائع أنه ضمن [ يقال ] معنى [ ينادي ] و[ إبراهيم ] نائب عن الفاعل وأورد على نفسه كيف عدى باللام والنداء لا يتعدى به وأجاب بأنه روعي الملفوظ به وهو القول لأنه يقال: قلت له.
الثاني: قوله: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ}، فإنه قد يقال: كيف يتعلق التكليف بالمرضع ؟ فأجيب بأنه ضمن [حرم] المعنى اللغوي وهو المنع. فاعترض كيف عدى بـ[علي] والمنع لا يتعدى به فأجيب بأنه روعي صورة اللفظ.
الثاني: أن التضمين يطلق على غير ما سبق قال القاضي أبو بكر في كتاب:" إعجاز القرآن" هو حصول معنى فيه من غير ذكره له باسم [أو صفة ] هي عبارة عنه ثم قسمه إلى قسمين أحدهما ما يفهم من البنية كقولك معلوم فإنه يوجب أنه لا بد من عالم.
والثاني من معنى العبارة [من حيث لا يصح إلا به] كالصفة فضارب يدل على مضروب.
قال: والتضمين كله إيجاز، قال: وذكر أن {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} من باب التضمين لأنه تضمن تعليم الاستفتاح في الأمور باسمه على جهة التعظيم لله تعالى أو التبرك باسمه.
وذكر ابن الاثير في كتاب:" المعاني المتبدعة " أن التضمين واقع في القرآن خلافا لماأجمع عليه أهل البيان وجعل منه قوله تعالى في الصافات: {لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْراً مِنَ الأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ}.
ويطلق التضمين أيضا على إدراج كلام الغير في أثناء الكلام لتأكيد المعنى،.
أو لترتيب النظم ويسمى الإبداع كإبداع الله تعالى في حكايات أقوال المخلوقين كقوله تعالى حكاية عن قول الملائكة: {قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ}.
ومثل ما حكاه عن المنافقين: {قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}.
وقوله: {أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ}.
{وَقَالَتِ الْيَهُودُ}.
{وَقَالَتِ النَّصَارَى}. ومثله في القرآن كثير.
وكذلك ما أودع في القرآن من اللغات الأعجمية.
ويقرب من التضمين في إيقاع فعل موقع آخر إيقاع الظن موقع اليقين في الأمور المحققة، كقوله تعالى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ}.
{الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ}.
{وَرَأى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا}.
{وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ}.
{وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ}.
وشرط ابن عطية في ذلك ألا يكون متعلقة حسيا كما تقول العرب في رجل يرى حاضرا: أظن هذا إنسانا وإنما يستعمل ذلك فيما لم يخرج إلى الحس بعد كالآيات السابقة.
قال الراغب في "الذريعة": الظن إصابة المطلوب بضرب من الإمارة متردد بين يقين وشك فيقرب تارة من طرف اليقين وتارة من طرف الشك فصار أهل اللغة يفسرونه بهما فمتى رئي إلى طرف اليقين أقرب استعمل معه أن المثقلة والمخففة فيهما كقوله تعالى: { الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ} {وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ}.
ومتى رئي إلى الشك أقرب استعمل معه أن التي للمعدومين من الفعل نحو ظننت أن يخرج.
قال: وإنما استعمل الظن بمعنى العلم في قوله: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ} لأمرين:.
أحدهما: للتنبيه على أن علم أكثر الناس في الدنيا بالنسبة إلى علمهم في الآخرة كالظن في جنب العلم.
والثاني: أن العلم الحقيقي في الدنيا لا يكاد يحصل إلا للنبيين والصديقين المعنيين بقوله: {الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} والظن متى كان عن أمارة قوية فإنه يمدح به ومتى كان عن تخمين لم يمدح به كما قال تعالى: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}.
وجوز أبو الفتح في قوله: {أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ} أن يكون المراد بها اليقين وأن تكون على بابها وهو أقوى في المعنى أي فقد يمنع من هذا التوهم فكيف عند تحقيق الأمر فهذا أبلغ كقوله: " يكفيك من شر سماعه " أي لو توهم البعث والنشور وما هناك من عظم الأمر وشدته لاجتنب المعاصي فكيف عند تحقق الأمر ! وهذا أبلغ.
وقيل: آيتا البقرة بمعنى الاعتقاد والباقي بمعنى اليقين والفرق بينهما أن الاعتقاد يقبل التشكيك بخلاف اليقين وإن اشتركا جميعا في وجوب الجزم بهما.
وكذلك قوله: {إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ}.
وقد جاء عكسه وهو التجوز عن الظن بالعلم، كقوله تعالى: {وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا}، ولم يكن ذلك علما جازما بل اعتقادا ظنيا.
وقوله: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} وكان يحكم بالظن وبالظاهر.
وقوله: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} وإنما يحصل بالامتحان في الحكم ووجه التجوز أن بين الظن والعلم قدرا مشتركا وهو الرجحان فتجوز بأحدهما عن الآخر.
وضع الخبر موضع الطلب في الأمر والنهي.
كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ}.
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ}.
{سَلامٌ عَلَيْكُمْ}.
{الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ}.
وقوله: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} الآية، ولهذا جعلها العلماء من أمثلة الواجب.
{فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ} على قراءة نافع أي لا ترفثوا ولا تفسقوا.
{وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ} ، قالوا: هو خبر وتأويله نهى أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله كقوله: {لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} وكقوله: {لا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} على قراءة الرفع وقيل إنه نهى مجزوم أعنى – قوله: {لا يَمَسُّهُ}- ولكن ضمت إتباعا للضمير كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ".
وقوله: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ} ضمن {لا تَعْبُدُونَ} معنى: لا تعبدوا، بدليل قوله بعده: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} وبه يزول الإشكال في عطف الإنشاء على الخبر لكن إن كان حسنا معمولا لأحسنوا فعطف.
[قولوا] عليه أولى لاتفاقهما لفظا ومعنى وإن كان التقدير:[ ويحسنون ] فهو الذي قبله والعطف على القريب أولى. وقيل: {لا تَعْبُدُونَ} أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن المنهي يسارع إلى الانتهاء فهومخبر عنه.
وكذا قوله: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ} في موضع [لا تسفكوا].
وقوله في سورة الصف: {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} عطفا على قوله: {تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} ولهذا جزم الجواب.
وقوله: {إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ} إلى قوله: {وَامْتَازُوا الْيَوْمَ} فإن المقام يشتمل على تضمين [إن أصحاب الجنة اليوم] معنى الطلب بدليل ما قبله: {فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً} فإنه كلام وقت الحشر لوروده ومعطوفا بالفاء على قوله: {إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ} وعام لجميع الخلق لعموم قوله: {لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً} وإن الخطاب الوارد بعده على سبيل الالتفات وهو قوله: {وَلا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} خطاب عام لأهل المحشر، فيكون قوله: {إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ} إلى قوله: {أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ} مقيدا بهذا الخطاب لكونه تفصيلا لما أجمله: {وَلا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} وإن التقدير أن أصحاب الجنة منكم يا أهل المحشر ثم جاء في التفسير أن قوله هذا: {إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ} يقال لهم حين يساق بهم إلى الجنة بتنزيل ما هو للتكوين منزلة الكائن أي إن أصحاب الجنة منكم يا أهل المحشر يؤول حالهم.
إلى أسعد حال والتقدير حينئذ: فامتازوا عنكم إلى الجنة، هكذا قرره السكاكي في"المفتاح".
قيل: وفيه نظر لأنها إذا كانت طلبية ومعناها أمر المؤمنين بالذهاب إلى الجنة فليكن الخطاب معهم لا مع أهل المحشر.
ولهذا قال بعضهم: إن تضمين أصحاب أهل الجنة للطلب ليس المراد منه أن الجملة نفسها طلبية بل معناه أن يقدر جملة إنشائية بعدها بخلاف قوله: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً}.
ومنه قوله تعالى: {تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} فإنه يقال: كيف جاء الجزم في جواب الخبر وجوابه أنه لما كان في معنى الأمر جاز ذلك إذ المعنى: آمنوا وجاهدوا.
وقال ابن جنى: لا يكون [يغفر] جوابا لـ[هل أدلكم] وإن كان أبو العباس قد قاله لأن المغفرة تحصل بالإيمان لا بالدلاة. انتهى. وقد يقال الدلالة: سبب السبب.
إذا علمت هذا فإنما يجيء الأمر بلفظ الخبر الحاصل تحقيقا لثبوته وأنه مما ينبغي أن يكون واقعا ولا بد وهذا هو المشهور.
وفيه طريقة أخرى نقلت عن القاضي ابي بكر وغيره وهي أن هذا خبر حقيقة غير مصروف عن جهة الخبرية ولكنه خبر عن حكم الله وشرعه ليس خبرا عن الواقع حتى يلزم ما ذكره من الإشكال وهو احتمال عدم وقوع مخبره فإن هذا إنما يلزم الخبر عن الواقع أما الخبر عن الحكم فلا لأنه لا يقع خلافه أصلا.
وضع الطلب موضع الخبر.
كقوله تعالى: {قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً}.
وقوله: {قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً}.
وقوله: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً}.
وقوله: {فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ} فقوله :{وألق} معطوف على قوله :{أن بورك} فـ[ألق] وإن كان إنشاء لفظا لكنه خبر معنى. والمعنى: فلما جاءها قيل: بورك من في النار وقيل: ألق.
والموجب لهذا قول النحاة إن أن هذه مفسرة لا تأتي إلا بعد فعل في معنىالقول وإذا قيل كتبت إليه أن ارجع وناداني أن قم كله بمنزلة: قلت له وقال لي قم كذا قاله صاحب المفتاح.
وما ذكره من أن بورك خبرية لفظا ومعنى ممنوع لجواز أن يكون دعاء وهو إنشاء وقد ذكر هذا التقدير الفارسي وابو البقاء فتكون الجملتان متفقتين في معنى الإنشاء فتكون مثل {لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ}.
وقوله: {يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ} إلى قوله: {وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} فإنه يقال: كيف ورد التمني على التكذيب وهو إنشاء ؟.
وأجاب الزمخشري أنه ضمن معنى العدة وأجاب غيره بأنه محمول على المعنى من الشرط والخبر كأنه قيل: إن زددنا لم نكذب وآمنا والشرط خبر فصح ورود التكذيب عليه.
وقوله: {اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} أي ونحن حاملون بدليل قوله: {إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} والكذب إنما يرد على الخبر.
وقوله: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} تقديره: ما أسمعهم وأبصرهم ! لأن الله تعالى لم يتعجب منهم ولكنه دل المكلفين على أن هؤلاء قد نزلوا منزلة من يتعجب منه.
ومما يدل على كونه ليس أمرا حقيقيا ظهور الفاعل الذي هو الجار والمجرور في الأول وفعل الأمر لا يبرز فاعله أبدا.
ووجه التجوز في هذا الأسلوب أن الأمر شأنه أن يكون ما فيه داعية للأمر وليس الخبر كذلك فإذا عبر عن الخبر بلفظ الأمر أشعر ذلك بالداعية فيكون ثبوته وصدقه أقرب. هذا بالنسبة لكلام العرب لا لكلام الله إذ يستحيل في حقه سبحانه الداعية للفعل.
بقى الكلام في أيهما أبلغ ؟ هذا القسم أو الذي قبله ؟.
قال الكواشي في قوله تعالى: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً} الأمر بمعنى الخبر لتضمنه اللزوم نحو إن زرتنا فلنكرمك يريدون تأكيد إيجاب الإكرام عليهم.
وقال الزمخشري في قوله تعالى: {لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ} ورود الخبر والمراد الأمر أو النهي أبلغ من صريح الأمر والنهي كأنه سورع فيه إلى الامتثال والخبر عنه.
وقال النووي في شرح "مسلم" في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها: وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه " ، هكذا هو في جميع النسخ ولا يسوم بالواو ولا يخطب بالرفع وكلاهما لفظه لفظ الخبر والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهي قد يقع مخالفته فكأن المعنى عاملوا هذا النهي معاملة خبر الحتم ثم قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ولا تسأل المرأة طلاق أختها " يجوز في تسأل الرفع والكسر والأول على الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله قبله: " لا يخطب ولا يسوم " والثاني على النهي الحقيقي. انتهى.
وضع النداء موضع التعجب
كقوله تعالى: {يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ} قال الفراء: معناه: فيالها من حسرة والحسرة في اللغة أشد الندم لأن القلب يبقى حسيرا.
وحكى أبو الحسين بن خالويه في كتاب:" المبتدأ " عن البصريين أن هذه من أصعب مسألة في القرآن لأن الحسرة لا تنادي وإنما تنادى الاشخاص لأن فائدته التنبيه ولكن المعنى على التعجب كقوله: يا عجبا لم فعلت! {يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ} وهو أبلغ من قولك: العجب. قيل: فكأن التقدير يا عجبا احضر يا حسرة احضري!.
وقرأ الحسن {يَا حَسْرَةَ العِبَادِ}.
ومنهم قال: الأصل [يا حسرتاه] ثم اسقطوا الهاء تخفيفا ولهذا قرأ عاصم {يَا أَسَفَاهُ عَلَى يُوسُفَ}.
وقال ابن جنى في كتاب:" الفسر ": معناه أنه لو كانت الحسرة مما يصح نداؤه لكان هذا وقتها.
وأما قوله تعالى: {يَا بُشْرَى}، فقالوا: معنى النداء فيما لا يعقل تنبيه المخاطب وتوكيد القصة فإذا قلت يا عجبا ! فكأنك قلت: اعجبوا فكأنه قال: يا قوم أبشروا.
قال أبو الفتح في:" الخاطريات": وقد توضع الجملة من المبتدأ والخبر موضع.
لمفعول به، كقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ} بعد قوله: {لَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا} المعنى: ولتنتفعوا بها عطفا على قوله: {لِتَرْكَبُوا مِنْهَا} وعلى هذا قال: {وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ}. وكذلك قوله: {وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} أي ولتأكلوا منها ولذلك أتى وعليها وعلى الفلك تحملون فعطف الجملة من الفعل ومرفوعة على المفعول له.
ونظيره قوله تعالى: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ} أي ولأني ربكم فاتقون فوضع الجملة من المبتدأ والخبر موضع المفعول له.
وبهذا يبطل تعلق من تعلق على ثبوته في قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} وقوله: إن هذا ليس من مواضع الابتداء لجواز تقدير وأذان بأن الله برىء وبأن رسوله كذلك.
وضع جمع القلة موضع الكثرة.
لأن الجموع يقع بعضها موقع بعض لاشتراكها في مطلق الجمعية كقوله تعالى: {وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ} فإن المجموع بالألف والتاء للقلة وغرف الجنة لا تحصى.
وقوله: {هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ} ورتب الناس في علم الله أكثر من العشرة لا محالة.
وقوله: { الله يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ}.
وقوله: {وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} وهو كثير.
وقيل: سبب ذلك في الآية الأولى دخول الألف واللام الجنسية فيكون ذلك تكثيرا لها وكان دخولها على جمع القلة أولى من دخولها على جمع الكثرة إشارة إلى قلة من يكون فيها ألا ترى أنه لا يكون فيها إلا المؤمنون !.
وقد نص سبحانه على قتلهم بالإضافة إلى غيرهم في قوله تعالى: {إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} فيكون التكثير الداخل في قوله: {وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ} لا من جهة وضع جمع القلة موضع جمع الكثرة ولكن من جهة ما اقتضته الألف واللام للجنس.
واعلم أن جموع التكثير الأربعة وجمعى التصحيح - أعنى جمع التأنيث وجمع التذكير - كل ذلك للقلة أما جموع التكسير فبالوضع وأما جمعا التصحيح، فلأنهما.
أقرب إلى التثنية، وهي أقل العدد فوجب أن يكون الجمع المشابه لها بمنزلتها في القلة وما عداها من الجموع فيرد تارة للقلة وتارة للكثرة بحسب القرائن قال تعالى: {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}.{هُدىً لِلْمُتَّقِينَ}.{وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}،{إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}.{أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ}.{إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} {وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} {وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً}{وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا} {فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} {بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ}{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} {وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}{ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ}{وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء} {وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى} {وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ} {بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} فإن قلت: ليس هذا منه بل هي للقلة لأنها خمس.
قلت: لو كان كذلك لما صح: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء}.
{فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} فالمراد منها واحد والجواب عن أحدهما الجواب عن الآخر.
وقوله تعالى: {مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ} {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ} {الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ} الآية.{وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} الآية.ولا تحصى كثرة.
ومن شواهد مجيء جمع القلة مرادا به الكثرة قول حسان رضي الله عنه:
لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى ... وأسيافنا يقطرن من نجدة دما
وحكى أن النابغة قال له:
قد قللت جفتاك وأسيافك ...
وطعن الفارسي في هذه الحكاية لوجود وضع جمع القلة موضع الكثرة فيما له جمع كثرة وفيما لا جمع له كثرة في كلامهم وصححها بعضهم قال يعنى أنه كان ينبغي لحسان تجنب اللفظ الذي أصله أن يكون في القلة وإن كان جائزا في اللسان وضعه لقرينة إذا كان الموضع موضع مدح أو أنه وإن كانت القلة لمعنى الكثرة لكن ليس في كل مقام.
ومن المشكل قوله تعالى: {فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً} فإن أضعافا جمع قلة فكيف جاء بعد كثرة !.
والجواب أن جمع القلة يستعمل مرادا به الكثرة وهذا منه.
تنبيهان:.
الأول: إنما يسأل عن حكمة ذلك حيث كان له جمع كثرة فإن لم يكن فلا.
كقوله: { أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ } فإن أياما أفعال مع أنها ثلاثون لكن ليس لليوم جمع غيره ومن ثم أفرد السمع وجمع الأبصار في قوله: {وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ} لأن فعلا ساكن العين صحيحها لا يجمع على أفعال غالبا وليس له جمع تكسير فلما كان كذلك اكتفى بدلالة الجنس على الجمع.
وجعل بعضهم من هذا أنفسكم على كثرتها في القرآن وليس كذلك فقد جاء {وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} وحكمته هنا ظاهرة لأن المراد استعياب جميع الخلق في المحشر.
ونظيره: {مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ} لإمكان الثمار وليس رأس آية.
منه: {آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} لإمكان آي ولا يقال إنه لطلب المشاكلة فقد قال تعالى بعده: {وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} فدل على عدم المشاكلة لإمكان أخريات.
وكذلك قوله: {تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ} وليس رأس آية ولا فيه مشاكلة لإمكان الأنهر.
وقد جاء أنفس للقلة، كقوله: {وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ} وقيل: المراد نفسان من باب :{فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}.
الثاني إنما يتم في المنكر أما المعرف فيستغنى بالعموم عن ذلك وبهذا يخدش في كثير مما سبق جعله من هذا النوع.وقد قال الزمخشري في قوله تعالى: {مِنَ الثَّمَرَاتِ} : إنه جمع قلة وضع موضع جمع الكثرة ورد عليه بأن [ أل ] في الثمرات للعموم فيصير كالثمار ولا حاجة إلى إرتكاب وضع جمع قلة موضع جمع كثرة وكذلك بيت حسان السابق فإن الجفنات معرفة [ أل ] وأسيافنا مضاف ليعم.
تذكير المؤنث.
يكثر في تأويله بمذكر، كقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ} على تأويلها بالوعظ.
وقوله: {وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً} على تأويل البلدة بالمكان وإلا لقال:[ ميتة ].
وقوله: {فَلَمَّا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي} أي الشخص أو الطالع.
وقوله: {قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ} أي بيان ودليل وبرهان.
وقوله: {وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً}.
وإنما يترك التأنيث كما يترك في صفات المذكر لا كما في قولهم: أمرأة معطار لأن السماء بمعنى المطر مذكر قال:
إذا نزل السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا
ويجمع على أسمية وسمي قال العجاج:
تلفه الأرواح والسمى ...
وقوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} إ لى قوله: {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} ذكر الضمير لأنه ذهب بالقسمة إلى المقسوم.
وقوله: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ} ذهب بالانعام إلى معنى النعم أو حمله على معنى الجمع.
وقوله: {إن رحمة الله قريب من المحسنين} ، ولم يقل قريبة قال الجوهري: ذكرت على معنى الإحسان. وذكر الفراء أن العرب تفرق بين النسب والقرب من المكان فيقولون: هذه قريبتي من النسب وقريبي من المكان فعلوا ذلك فرقا بين قرب النسب والمكان.
قال الزجاج: وهذا غلط لأن كل ما قرب من مكان ونسب فهو جار على ما يقتضيه من التذكير والتأنيث يريد أنك إذا أردت القرب من المكان قلت زيد قريب من عمرو وهند قريبة من العباس فكذا في النسب.
وقال أبو عبيدة: ذكر [ قريب ] لتذكير المكان أي مكانا قريبا. ورده ابن الشجري بأنه لو صح لنصب [ قريب ] على الظرف.
وقال الأخفش: المراد بالرحمة هنا المطر لأنه قد تقدم ما يقتضيه فحمل المذكر عليه.
وقال الزجاج: لأن الرحمة والغفران بمعنى واحد وقيل لأنها والرحم سواء.
ومنه: {وَأَقْرَبَ رُحْماً} فحملوا الخبر على المعنى ويؤيده قوله تعالى: {هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي}.
وقيل: الرحمة مصدر والمصادر كما لا تجمع لا تؤنث.
وقيل:[ قريب ] على وزن [فعيل] [وفعيل] يستوي فيها المذكر والمؤنث حقيقيا كان أو غير حقيقي. ونظيره قوله تعالى: {وَهِيَ رَمِيمٌ}.
وقيل: من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مع الالتفات إلى المحذوف فكأنه قال: وإن مكان رحمة الله قريب ثم حذف المكان وأعطى الرحمة إعرابه وتذكيره.
وقيل: من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أي إن رحمة الله شيء قريب أو لطيف أو بر أو إحسان.
وقيل: من باب إكساب المضاف حكم المضاف إليه إذا كان صالحا للحذف والاستغناء عنه بالثاني والمشهور في هذا تأنيث المذكر لإضافته إلى مؤنث كقوله:
مشين كما اهتزت رماح تسفهت ... أعاليها مر الرياح النواسم
فقال: تسفهت والفاعل مذكر لأنه اكتسب تأنيثا من الرياح إذ الاستغناء عنه جائز وإذا كانت الإضافة على هذا تعطى المضاف تأنيثا لم يكن له فلأن تعطيه تذكيرا لم يكن له كما في الآية الكريمة أحق وأولى لأن التذكير أولى والرجوع إليه أسهل من الخروج عنه.
وقيل: من الاستغناء بأحد المذكورين لكون الاخر تبعا له ومعنى من معاينة.
ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى: {فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} فاستغنى عن خبر الأعناق بخبر أصحابها والأصل هنا إن رحمة الله قريب وهو قريب من المحسنين فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود وسوغ ظهور ذلك المعنى.
ونظير هذه الآية الشريفة قوله تعالى: {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ}، قال البغوى: لم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي ومجازها الوقت.
وقال الكسائي: إتيانها قريب.
وقيل في قوله تعالى: {بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ} ولم يقل: [صرصرة] كما قال: {بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ} لأن الصرصر وصف مخصوص بالريح لا يوصف به غيرها فأشبه باب [حائض] ونحوه بخلاف [عاتية] فإن غير الريح من الأسماء المؤنثة يوصف به.
وأما قوله تعالى: {السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ} ففي تذكير [منفطر] خمسة أقوال:.
أحدها : للفراء أن السماء تذكر وتؤنث فجاء [منفطر] على التذكير.
والثاني : لأبي على أنه من باب اسم الجنس الذي بينه وبين واحده التاء مفرده سماءة واسم الجنس يذكر ويؤنث نحو: {أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ}.
والثالث: للكسائي أنه ذكر حملا على معنى السقف.
والرابع : لأبي علي أيضا على معنى النسب أي ذات انفطار كقولهم امرأة مرضع أي ذات رضاع.
والخامس: للزمخشري أنه صفة لخبر محذوف مذكر أي شيء منفطر.
وسأل أبو عثمان المازني بحضرة المتوكل قوما من النحويين منهم ابن السكيت وأبو بكر بن قادم عن قوله تعالى: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً}: كيف جاء بغيرها.
ونحن نقول: امرأة كريمة إذا كانت هي الفاعل وليست بمنزلة [القتيل] التي هي بمعنى [المفعول] ؟ فأجاب ابن قادم وخلط فقال له المتوكل: أخطأت قل يا بكر للمازني قال: بغي ليس لـ[فعيل] وإنما هو [فعول] والأصل فيه [بغوى] فلما التقت واو وياء وسبقت إحدهما بالسكون أدغمت الواو في الياء فقيل:[ بغى ]كما تقول: امرأة.
صبور بغير هاء لأنها بمعنى صابرة فهذا حكم فعول إذا عدل عن فاعله فإن عدل عن مفعوله جاء بالهاء كما قال.
*منها اثنتان واربعون حلوبة*
بمعنى [محلوبة] حكاه التوحيدي في "البصائر".
وقال البغوي في قوله تعالى: {مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} ولم يقل: [رميمة] لأنه معدول عن فاعله وكلما كان معدولا عن جهته ووزنه كان مصروفا عن فاعلة كقوله: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً} اسقط الهاء لأنها مصروفة عن [باغية].
وقال الشريف المرتضى في قوله تعالى: {وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} إن الضمير في ذلك يعود للرحمة وإنما لم يقل و[لتلك] لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي كقوله تعالى: {هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي} ولم يقل [هذه] على أن قوله: {إِلاَّ مَنْ رَحِمَ} كما يدل على الرحمة يدل على أن [يرحم] ويجوز رجوع الكتابة إلى قوله إلا أن يرحم والتذكير في موضعه.
قال: ويجوز أن يكون قوله: {وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} كناية عن اجتماعهم على الإيمان وكونهم فيه أمة واحدة ولا محالة أنه لهذا خلقهم.
ويطابق هذه الآية قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}، قال: فأما قوله: {وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} فمعناه الاختلاف في الدين والذهاب عن الحق فيه.
بالهوى والشبهات. وذكر أبو مسلم بن بحر فيه معنى غريبا فقال: معناه أن خلف هؤلاء الكفار يخلف سلفهم في الكفر لأنه سواء قولك: خلف بعضهم بعضا وقولك اختلفوا كما سواء قولك: قتل بعضهم بعضا وقولهم: اقتتلوا. ومنه قولهم: لا أفعله ما اختلف العصران، [والجديدان]، أي جاء كل واحد منهم بعد الآخر.
واختلف في قوله: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ}، فقال الكسائي: أي من بطون ما ذكرنا.
وقال الفراء: ذكر لأنه ذهب إلى المعنى يعنى معنى النعم وقيل: الأنعام تذكر وتؤنث.
وقال أبو عبيدة: أراد البعض أي من بطون أيها كان ذا لبن.
وأنكر أبو حاتم تذكير الأنعام لكنه أراد معنى النعم.
تأنيث المذكر.
كقوله تعالى: {الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا} فأنث [ الفردوس ] وهو مذكر، حملا على معنى الجنة.
وقوله: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} ، فأنث [ عشر ] حيث جردت من الهاء مع إضافته إلى الأمثال وواحدها مذكر وفيه أوجه:.
أحدها: أنث لإضافة الأمثال إلى مؤنث، وهو ضمير الحسنات والمضاف يكتسب أحكام المضاف إليه فتكون كقوله: {يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ}.
والثاني : هو من باب مراعاة المعنى لأن الأمثال في المعنى مؤنثه لأن مثل الحسنة حسنة لا محالة فلما أريد توكيد الإحسان إلى المطيع وأنه لا يضيع شيء من علمه كأن الحسنة المنتظرة واقعة جعل التأنيث في أمثالها منبهة على ذلك الوضع وإشارة إليه كما جعلت الهاء في قولهم: رواية وعلامة تنبيها على المعنى المؤنث المراد في أنفسهم وهو الغاية والنهاية ولذلك أنث المثل هنا توكيدا لتصوير الحسنة في نفس المطيع ليكون ذلك أدعى له إلى الطاعة حتى كأنه قال فله عشر حسنات أمثالها حذف وأقيمت صفته مقامه وروعي ذلك المحذوف الذي هو المضاف إليه كما يراعى المضاف في نحو قوله: {أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ}، أي أو [كذى ظلمات] وراعاه في قوله: {يَغْشَاهُ مَوْجٌ}، وهذا الوجه هو الذي عول عليه الزمخشري ولم يذكر سواه.
وأما ابن جنى فذكر في "المحتسب" الوجه الأول وقال: فإن قلت: فهلا حملته.
على حذف الموصوف فكأنه قال:[ فله عشر حسنات وأمثالها ]؟ قيل: حذف وإقامة الموصوف مقامه ليس بمستحسن في القياس وأكثر ما أتى في الشعر ولذلك حمل{دانية}من قوله: {وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا}، على أنه وصف جنة أو [وجنة دانية] عطف على [جنة] من قولهم: {وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً} ، لما قدر حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه حتى عطف على قوله: {مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ} فكانت حالا معطوفة على حال.
وفي "كشف المشكلات" للأصبهاني: حذف الموصوف هو اختيار سيبويه وإن كان لا يرى حسن [ثلاثة مسلمين]، بحذف الموصوف.
وقوله تعالى حكاية عن لقمان: {يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ} فأنث الفعل المسند لـ[مثقال] وهو مذكر ولكن لما أضيف إلى [حبة] اكتسب منه التأنيث فساغ تأنيث فعله.
وذكر أبو البقاء في قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} أن التأنيث في [ذائقة] باعتبار معنى [كل] لأن معناها التأنيث قال: لأن كل نفس نفوس ولو ذكر على لفظ [كل] جاز يعنى - أنه لو قيل كل نفس ذائق جاز.
وهو مردود لأنه يجب اعتبار ما يضاف إليه [كل] إذا كانت نكرة ولا يجوز أن يعتبر كل.
وقوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ}، فإن الظاهر عود الضمير إلى الإبداء بدليل قوله: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}، فذكر الضمير العائد على الإخفاء ولو قصد الصدقات لقال: [فهي] وإنما أنث [هي] والذي عاد إليه مذكر على حذف مضاف أي وإبداؤها نعم ما هي كقوله: القرية أسألها.
ومنه: {سَعِيراً} وهو مذكر، ثم قال: {إِذَا رَأَتْهُمْ} فحمله على النار.
وأما قوله: { لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ}، فقيل: الضمير عائد على الآيات المتقدمة في اللفظ.
وقال البغوي: إنما قال: {خَلَقَهُنَّ}، بالتأنيث، لأنه أجرى على طريق جمع التكسير ولم يجر على طريق التغليب للمذكر على المؤنث لأنه فيما لا يعقل.
وقيل: في قوله: {الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}: إن المراد آدم فأنثه ردا إلى النفس. وقد قرىء شاذا [ من نفس واحد ].
وحكى الثعلبي في تفسيره في سورة " اقترب " بإسناده إلى المبرد، سئل عن ألف مسألة، منها: ما الفرق بين قوله تعالى: {جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ} وقوله: {وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً} وقوله: {أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} و{كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ.
نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} ، فقال: كل ما ورد عليك من هذا الباب، فلك أن ترده إلى اللفظ تذكيرا ولك أن ترده إلى المعنى تأنيثا وهذا من قاعدة أن اسم الجنس تأنيثه غير حقيقي فتارة يلحظ معنى الجنس فيذكر وتارة معنى الجماعة فيؤنث قال تعالى في قصة شعيب: {وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ}، وفي قصة صالح: {وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ}. وقال: {إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا} وقرئ:[ تشابهت ].
وأبدى السهيلي للحذف والإثبات معنى حسنا فقال: إنما حذفت منه لأن [الصيحة] فيها بمعنى العذاب والخزي إذ كانت منتظمة بقوله: {وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ} فقوى التذكير بخلاف قصة شعيب فإنه لم يذكر فيها ذلك.
وأجاب غيره: بأن الصيحة يراد بها المصدر بمعنى الصياح فيجىء فيها التذكير فيطلق ويراد بها الوحدة من المصدر فيكون التأنيث أحسن.
وقد أخبر سبحانه عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مفردة اللفظ:.
أحدها : الرجفة في قوله: {فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ}.
والثاني: الظلة في قوله: {فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ}.
والثالث: الصيحة وجمع لهم الثلاثة لأن الرجفة بدأت بهم فأصحروا في الفضاء خوفا من سقوط الأبنية عليهم فضربتهم الشمس بحرها ورفعت لهم الظلة فهرعوا إليها يستظلون بها من الشمس فنزل عليهم العذاب وفيه الصيحة فكان ذكر الصيحةمع الرجفة والظلة أحسن من ذكر الصياح فكان ذكر التاء أحسن.
فإن قلت: ما الفرق بين قوله سبحانه: {فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ} وبين قوله: {فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ}.
قيل: الفرق بينهما من وجهين:.
لفظي ومعنوي:.
أما اللفظي، فهو أن الفصل بين الفعل والفاعل في قوله: {حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ}، أكثر منها في قوله: {حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ} والحذف مع كثرة الحواجز أحسن.
وأما المعنوى، فهو أن [مَن] في قوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ} راجعة على الجماعة وهي مؤنثة لفظا، بدليل {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً}، ثم قال: {وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ} ، أي من تلك الأمم ولو قال: [ضلت] لتعينت التاء - والكلامان واحد وإن كان معناهما واحدا - فكان إثبات التاء أحسن من تركها لأنها ثابتة فيما هو من معنى الكلام المتأخر.
وأما {فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ}، فالفريق مذكر ولو قال: [ضلوا] لكان بغير تاء وقوله: {حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ} في معناه، فجاء بغير تاء وهذا أسلوب لطيف من أساليب العرب أن يدعو حكم اللفظ الواجب في قياس لغتهم إذا كان في مركبه كلمة لا يجب لها حكم ذلك الحكم.
تنبيه:.
جاء عن ابن مسعود ذكروا القرآن. ففهم منه ثعلب أن ما احتمل تأنيثه وتذكيره كان تذكيره أجود.
ورد بأنه يمتنع إرادة تذكير غير الحقيقي التأنيث لكثرة ما في القرآن منه بالتأنيث: {النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ} {وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ} {قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ}.
وإذا امتنع إرادة غير الحقيقي، فالحقيقي أولى.
قالوا: ولا يستقيم إرادة أن ما احتمل التذكير والتأنيث غلب فيه التذكير لقوله تعالى: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ}. {أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ}، فأنث مع جواز التذكير قال تعالى: {أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ}، {مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ} قال: فليس المراد ما فهم بل المراد الموعظة والدعاء كما قال تعالى: {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ} إلا أنه حذف الجار والمقصود ذكروا الناس بالقرآن أي ابعثوهم على حفظه كيلا ينسوه.
وقال الواحدي: إن قول ابن مسعود على ما ذهب إليه ثعلب والمراد أنه إذا احتمل اللفظ التذكير والتأنيث ولم يحتج في التذكير إلى مخالفة المصحف ذكر نحو: {وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ}.
قال: ويدل على إرادته هذا إن أصحاب عبد الله من قراء الكوفة كحمزة والكسائي ذهبوا إلى هذا فقرءوا ما كان من هذا القبيل بالتذكير، نحو: {يَوْمَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ} وهذا في غير الحقيقي.
ضابط الثأنيث.
ضابط التأنيث ضربان:.
حقيقي وغيره، فالحقيقي: لا يحذف التأنيث من فعله غالبا إلا أن يقع فصل نحو:.
قام اليوم هند، وكلما كثر الفصل حسن الحذف والإثبات مع الحقيقي أولى ما لم يكن جمعا.
وأما غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل حسن، قال تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ} ، فإن كثر الفصل ازداد حسنا، ومنه: { وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ} ويحسن الإثبات ايضا نحو: {وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ} فجمع بينهما في سورة هود.
وأشار بعضهم إلى ترجيح الحذف، واستدل عليه بأن الله تعالى قدمه عليه حيث جمع بينهما في سورة واحدة. وفيما قاله نظر.
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه.
قد سبق منه كثير في نوع الالتفات ويغلب ذلك فيما إذا كان مدلول الفعل من الأمور الهائلة المهددة المتوعد بها فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريرا وتحقيقا لوقوعه كقوله تعالى: {وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ}.
وقوله في الزمر: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ}.
وقوله: {وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً}.
وقوله: {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ} أي نحشرهم.
وقوله: {وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً}. ثم تارة يجعل المتوقع فيه كالواقع فيؤتى بصيغة الماضي مرادا به المضي تنزيلا للمتوقع منزلة ما وقع فلا يكون تعبيرا عن المستقبل بلفظ الماضي بل جعل المستقبل ماضيا مبالغة.
ومنه: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ}. {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} ونحوه.
وقد يعبر عن المستقبل بالماضي مرادا به المستقبل فهو مجاز لفظي كقوله تعالى:.
{وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ} ، فإنه لا يمكن أن يراد به المضي لمنافاة {يُنْفَخُ} الذي هو مستقبل في الواقع. وفائدة التعبير عنه بالماضي الإشارة إلى استحضار التحقق وإنه من شأنه لتحققه أن يعبر عن بالماضي وإن لم يرد معناه والفرق بينهما أن الأول مجاز والثاني لا مجاز فيه إلا من جهة اللفظ فقط.
وقوله: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى}، أي يقول، عكسه لأن المضارع يراد به الديمومة والاستمرار كقوله: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ}.
وقوله: {ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}، أي فكان استحضارا لصورة تكونه.
وقوله: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ}، أي ما تلت.
وقوله تعالى: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ}، أي علمنا.
فإن قيل: كيف يتصور التقليل في علم الله ؟.
قيل: المراد أنهم أقل معلوماته ولأن المضارع هنا بمعنى الماضي ف قد فيه للتحقيق لا التقليل.
وقوله: {فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ} أي فلم قتلتم !.
وقوله: {حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} أي لم يتعارفوا حتى تأتيهم.
وقوله: {مُنْفَكِّينَ} قال مجاهد: منتهين وقيل: زائلين من الدنيا.
وقال الأزهري: ليس هو من باب [ما انفك] و[مازال] إنما هو من انفكاك الشيء إذا انفصل عنه.
وقوله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ}، المعنى: فلم عذب آباءكم بالمسخ والقتل؟ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يؤمر بأن يحتج عليهم بشىء لم يكن بعد لأن الجاحد يقول: إني لا أعذب لكن احتج عليهم بما قد كان.
وقوله: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً}.
فعدل عن لفظ [أصبحت] إلى [تصبح] قصد للمبالغة في تحقيق اخضرار الأرض لأهميته إذ هو المقصود بالإنزال.
فإن قلت: كيف قال النحاة: إنه يجب نصب الفعل المقرون بالفاء إذا وقع في جواب الاستفهام، كقوله: {فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا} و[فتصبح] هنا مرفوع ؟.
قلت: لوجوه:.
أحدها: أن شرط الفاء المقتضية للنصب أن تكون سببية وهنا ليست كذلك بل هي لإستئناف لأن الرؤية ليست سببا للإصباح.
الثاني: أن شرط النصب أن ينسبك من الفاء وما قبلها شرط وجزاء وهنا ليس كذلك لأنه لو قيل: إن تر أن الله أنزل ماء تصبح لم يصح لأن إصباح الأرض حاصل سواء رئي أم لا.
فإن قيل: شاع في كلامهم إلغاء فعل الرؤية كما في قوله:[ ولا تزال- تراها- ظالمة ].
أي ولا تزال ظالمة وحينئذ فالمعنى منصب إلى الإنزال لا إلى الرؤية ولا شك أنه يصح أن يقال إن أنزل تصبح فقد انعقد الشرط والجزاء.
قلت: إلغاء فعل الرؤية في كلامهم جائز لا واجب فمن أين لنا ما يقتضي تعيين حمل الآية عليه ؟.
الثالث: إن همزة الاستفهام إذا دخلت على موجب تقلبه إلى النفي، كقوله تعالى: {أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ}، وإذا دخلت على نفي تقلبه إلى الإيجاب فالهمزة في الآية للتقرير فلما انتقل الكلام من النفي إلى الإيجاب لم ينتصب الفعل لأن شرط النفي كون السابق منفيا محضا: ذكره العزيزي في "البرهان".
ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة السجدة: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً}.
الرابع : أنه لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض لأن معناه إثبات الاخضرار فكان ينقلب النصب إلى نفي الاخضرار مثاله أن تقول لصاحبك ألم تر أني أنعمت فتشكر إن نصبت فأنت ناف لشكره شاك تفريطه وإن رفعت فأنت مثبت لشكره. ذكر هذا الزمخشري في الكشاف قال وهذا ومثاله مما يجب أن يرغب له من أتسم بالعلم في علم الإعراب وتوقير أهله.
وقال ابن الخباز: النصب يفسد المعنى لأن رؤية المخاطب الماء الذي أنزله الله ليس سببا للاخضرار وإنما الماء نفسه هو سبب الاخضرار.
ومنه قوله تعالى: {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ}،.
فقال: [تثير] مضارعا وما قبله وما بعده ماضيا مبالغة في تحقيق إثارة الرياح الساحب للسامعين وتقدير تصوره في أذهانهم.
فإن قيل: أهم الأفعال المذكورة في الآية إحياء الموتى وقد ذكر بلفظ الماضي وما ذكرته يقتضي أولوية ذكره بلفظ المضارع إذ هو أهم وإثارة السحاب سبب أعيد على قريب.
قيل: لا نسلم بأهمية إحياء الأرض بعد موتها فالمقدمات المذكورة أهمها وأدلها على القدرة أعجبها وأبعدها عن قدرة البشر وإثارة السحاب أعجبها فكان أولى بالتخصيص بالمضارع وإنما قال: إن إثارة السحاب أعجب لأن سببها أخفى من حيث إنا نعلم بالفعل أن نزول الماء سبب في اخضرار الأرض وإثارة السحاب وسوقه سبب نزول الماء.
فلو خلينا وظاهر العقل لم نقل إن الرياح سببها لعدم إحساسنا بمادة السحاب وجهته.
ومن لواحق ذلك العدول عن المستقبل إلى اسم المفعول لتضمنه معنى الماضي، كقوله: {يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ}، تقريرا للجمع فيه وأنه لا بد أن يكون معادا للناس مضروبا لجميعهم وإن شئت فوازن بينه وبين قوله : {يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ}، لتعرف صحة هذا المعنى.
فإن قلت: الماضي أدل على المقصود من أسم المفعول فلم عدل عنه إلى ما دلالته أضعف ؟ قلت: لتحصل المناسبة بين [مجموع] و[مشهور] في استواء شأنهما طلبا للتعديل في العبارة.
ومنه العدول عن المستقبل إلى اسم الفاعل، كقوله تعالى: {وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ} فإن اسم الفاعل ليس حقيقة في الاستقبال بل في الحال.