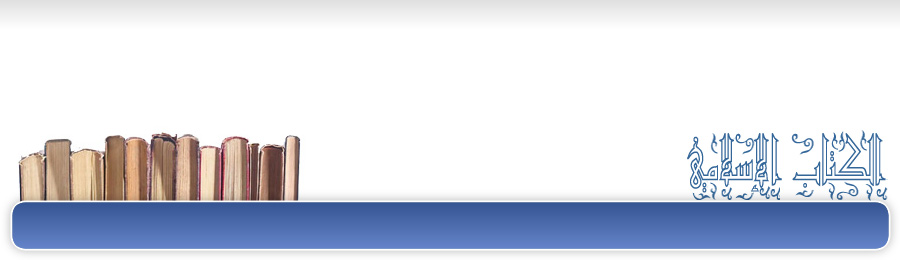كتاب : مقدمة ابن خلدون
المؤلف : ابن خلدون
والسبب في ذلك كما قدمناه أن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية وتفرد الوجهة إلى الحق فإذا حصل لهم الاستبصار في أمرهم لم يقف لهم شيء لأن الوجهة واحدة والمطلوب متساو عندهم، وهم مستميتون عليه، وأهل الدولة التي هم طالبوها وإن كانوا أضعافهم فأغراضهم متباينة بالباطل، وتخاذلهم لتقية الموت حاصل، فلا يقاومونهم وإن كانوا أكثر منهم، بل يغلبون عليهم ويعاجلهم الفناء بما فيهم من الترف والذل كما قدمناه.
وهذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات. فكانت جيوش المسلمين بالقادسية واليرموك بضعاً وثلاثين ألفاً في كل معسكر، وجموع فارس مائة وعشرين ألفاً بالقادسية، وجموع هرقل على ما قاله الواقدي أربعمائة ألف، فلم يقف للعرب أحد من الجانبين، وهزموهم وغلبوهم على ما بأيديهم.
واعتبر ذلك أيضاً في دولة لمتونة ودولة الموحدين. فقد كان بالمغرب من القبائل كثير ممن يقاومهم في العدد والعصبية أو يشف عليهم، إلا أن الاجتماع الديني ضاعف قوة عصبيتهم بالاستبصار والاستماتة كما قلناه، فلم يقف لهم شيء.
واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الدين، وفسدت، كيف ينتقض الأمر ويصير الغلب على نسبة العصبية وحدها دون زيادة الدين فتغلب الدولة من كان تحت يدها من العصائب المكافئة لها أو الزائدة القوة عليها الذين غلبتهم بمضاعفة الدين لقوتها، ولو كانوا أكثر عصبية منها وأشد بداوة.
واعتبر هذا في الموحدين مع زناتة، لما كانت زناتة أبدى من المصامدة وأشد توحشاً، وكان للمصامدة الدعوة الدينية بأتباع المهدي فلبسوا صبغتها وتضاعفت قوة عصبيتهم بها، فغلبوا على زناتة أولاً وأستتبعوهم، وإن كانوا من حيث العصبية والبداوة أشد منهم، فلما خلوا عن تلك الصبغة الدييية انتقضت عليهم زناتة من كل جانب وغلبوهم على الأمر وانتزعوه منهم. والله غالب على أمره.
الفصل السادس
في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم
وهذا لما قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكافة فلا بد له من العصبية. وفي الحديث الصحيح كما مر " ما بعث الله نبياً إلا في منعة من قومه " وإذا كان هذا في الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد، فما ظنك بغيرهم ألا تخرق له العادة في الغلب بغير عصبية.وقد وقع هذا لابن قسي شيخ الصوفية وصاحب كتاب خلع النعلين في التصوف، ثار بالأندلس داعياً إلى الحق وسمي أصحابه بالمرابطين قبيل دعوة المهدي، فاستتب له الأمر قليلاً لشغل لمتونة بما دهمهم من أمر الموحدين، ولم تكن هناك عصائب ولا قبائل يدعونه عن شأنه، فلم يلبث حين استولى الموحدون على المغرب أن أذعن لهم ودخل في دعوتهم، وتابعهم من معقله بحصن أركش، وأمكنهم من ثغره، وكان أول داعية لهم بالأندلس، وكانت ثورتة تسمى ثورة المرابطين.
ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء. فإن كثيراً من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجورمن الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه، والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم والمتشبثون بهم من الغوغاء والدهماء، ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في تلك السبيل مأزورين غير مأجورين، لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم، وإنما أمر به حيث تكون القدرة عليه، قال: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه " وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهم بناءها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر كما قدمناه.
وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر والعصائب، وهم المؤيدون من الله بالكون كله لو شاء، لكنه إنما أجرى الأمور على مستقر العادة. والله حكيم عليم.
فإذا ذهب أحد من الناس هذا المذهب وكان فيه محقاً قصر به الانفراد عن العصبية، فطاح في هوة الهلاك. وأما إن كان من الملبسين بذلك في طلب الرئاسة، فأجدر أن تعوقه العوائق وتنقطع به المهالك، لأنه أمر الله لا يتم إلا برضاه وإعانته والإخلاص له والنصيحة للمسلمين، ولا يشك في ذلك مسلم، ولا يرتاب فيه ذو بصيرة.
وأول ابتداء هذه النزعة في الملة ببغداد حين وقعت فتنة طاهر وقتل الأمين وأبطأ المأمون بخراسان عن مقدم العراق، ثم عهد لعلي بن موسى الرضا من آل الحسين، فكشف بنو العباس عن وجه النكير عليه وتداعوا للقيام وخلع طاعة المأمون والاستبدال منه، وبويع إبراهيم بن المهدي، فوقع الهرج ببغذاد وانطلقت أيدي الزعرة بها من الشطار والحربية على أهل العافية والصلاح، وقطعوا السبيل، وامتلأت أيديهم من نهاب الناس وباعوها علانية في الأسواق، واستعدى أهلها الحكام فلم يعدوهم. فتوافر أهل الدين والصلاح على منع الفساق وكف عاديتهم. وقام ببغداد رجل يعرف بخالد الدريوس، ودعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأجابه خلق وقاتل أهل الزعارة فغلبهم، وأطلق يده فيهم بالضرب والتنكيل.
ثم قام من بعده رجل آخر من سواد أهل بغداد يعرف بسهل بن سلامة الأنصاري، ويكنى أبا حاتم، وعلق مصحفاً في عنقه ودعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاتبعه الناس كافة من بين شريف ووضيع من بني هاشم فمن دونهم، ونزل قصر طاهر، واتخذ الديوان وطاف ببغداد، ومنع كل من أخاف المارة، ومنع الخفارة لأولئك الشطار. وقال له خالد الدريوس: أنا لا اعيب على السلطان، فقال له سهل: لكني أقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كائناً من كان. وذلك سنة إحدى ومائتين. وجهز له إبراهيم بن المهدي العساكر فغلبه وأسره وانحل أمره سريعاً وذهب ونجا بنفسه.
ثم اقتدى بهذا العمل بعد كثير من الموسوسين يأخذون أنفسهم بإقامة الحق ولا يعرفون ما يحتاجون إليه في إقامته من العصبية، ولا يشعرون بمغبة أمرهم ومآل أحوالهم. والذي يحتاج إليه في أمر هؤلاء إما المداواة إن كانوا من أهل الجنون، وإما التنكيل بالقتل أو الضرب إن أحدثوا هرجاً، وإما إذاعة السخرية منهم وعدهم من جملة الصقاعين.
وقد ينتسب بعضهم إلى الفاطمي المنتظر إما بأنه هو أو بأنه داع له، وليس مع ذلك على علم من أمر الفاطمي، ولا ما هو. وأكثر المنتحلين لمثل هذا تجدهم موسوسين أو مجانين أو ملبسين يطلبون بمثل هذه الدعوة رئاسة امتلأت بها جوانحهم وعجزوا عن التوصل إليها بشيء من أسبابها العادية، فيحسبون أن هذا من الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك، ولا يحسبون ما ينالهم فيه من الهلكة، فيسرع إليهم القتل بما يحدثونه من الفتنة، وتسوء عاقبة مكرهم.
وقد كان لأول هذه المائة خرج بالسوس رجل من المتصوفة يدعى التوبذري، عمد إلى مسجد ماسة بساحل البحر هنالك، وزعم أنه الفاطمي المنتظر، تلبيساً على العامة هنالك، بما ملأ قلوبهم من الحدثان بانتظاره هنالك، وأن من ذلك المسجد يكون أصل دعوته. فتهافتت عليه طوائف من عامة البربر تهافت الفراش. ثم خشي رؤساؤهم اتساع نطاق الفتنة، فدس إليه كبير المصامدة يومئذ عمر السكسيوي من قتله في فراشه.
وكذلك خرج في غمارة أيضاً لأول هذه المائة رجل يعرف بالعباس، وادعى مثل هذه الدعوة واتبع نعيقه الأرذلون من سفهاء تلك القبائل وأغمارهم، وزحف إلى بادس من أمصارهم ودخلها عنوة ثم قتل لأربعين يوماً من ظهور دعوته، ومضى في الهالكين الأولين.
وأمثال ذلك كثير، والغلط فيه من الغفلة عن اعتبار العصبية في مثلها. وأما إن كان التلبيس فأحرى ألا يتم له أمر وأن يبوء بإثمه وذلك جزاء الظالمين. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق لارب غيره ولا معبود سواه.
الفصل السابع
في أن كل دولة لها حصة من الممالك
والأوطان لا تزيد عليها والسبب في ذلك أن عصابة الدولة وقومها القائمين بها الممهدين لها لا بد من توزيعهم حصصاً على الممالك والثغور التي تصير إليهم، ويستولون عليها لحمايتها من العدو، وإمضاء أحكام الدولة فيها من جباية وردع وغير ذلك. فإذا توزعت العصائب كلها على الثغور والممالك فلا بد من نفاد عددها، وقد بلغت الممالك حينئذ إلى حد يكون ثغراً للدولة، وتخماً لوطنها، ونطاقاً لمركز ملكها. فإن تكلفت الدولة بعد ذلك زيادة على ما بيدها بقي دون حامية وكان موضعاً لانتهاز الفرصة من العدو والمجاور، ويعود وبال ذلك على الدولة، بما يكون فيه من التجاسر وخرق سياج الهيبة.وما كانت العصابة موفورة ولم ينفذ عددها في توزيع الحصص على الثغور والنواحي، بقي في الدولة قوة على تناول ما وراء الغاية، حتى ينفسح نطاقها إلى غايته. والعلة الطبيعية في ذلك هي قوة العصبية من سائر القوى الطبيعية، وكل قوة يصدر عنها فعل من الأفعال فشأنها ذلك في فعلها. والدولة في مركزها أشد مما يكون في الطرف والنطاق. وإذا انتهت إلى النطاق الذي هو الغاية عجزت وأقصرت عما وراءه، شأن الأشعة والأنوار إذا انبعثت من المراكز والدوائر المنفسحة على سطح الماء من النقر عليه. ثم إذا أدركها الهرم والضعف فإنما : تأخذ في التناقص من جهة الأطراف ولا يزال المركز محفوظاً إلى أن يتأذن الله بانقراض الأمر جملة، فحينئذ يكون انقراض المركز. وإذا غلب على الدولة من مركزها فلا ينفعها بقاء الأطراف والنطاق بل تضمحل لوقتها فإن المركز كالقلب الذي تنبعث منه الروح، فإذا غلب القلب وملك انهزم جميع الأطراف.
وانظر هذا في الدولة الفارسية. كان مركزها المدائن، فلما غلب المسلمون على المدائن انقرض أمر فارس أجمع، ولم ينفع يزدجرد ما بقي بيده من أطراف ممالكه. وبالعكس من ذلك الدولة الرومية بالشام، لما كان مركزها القسطنطينية، وغلبهم المسلمون بالشام تحيزوا إلى مركزهم بالقسطنطينية ولم يضرهم انتزاع الشام من أيديهم، فلم يزل ملكهم متصلاً بها إلى أن تأدن الله بانقراضه.
وانظر أيضاً شأن العرب أول الإسلام لما كانت عصائبهم موفورة، كيف غلبوا على ما جاورهم من الشام والعراق ومصر، لأسرع وقت، ثم تجاوزوا ذلك إلى ما وراءه من السند والحبشة وإفريقية والمغرب، ثم إلى الأندلس. فلما تفرقوا حصصاً على الممالك والثغور، ونزلوها حامية، ونفد عددهم في تلك التوزيعات، أقصروا عن الفتوحات بعد، وانتهى أمر الإسلام، ولم يتجاوز تلك الحدود، ومنها تراجعت الدولة حتى تأذن الله با نقراضها.
وكذا كان حال الدول من بعد ذلك، كل دولة على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة، وعند نفاد عددهم بالتوزيع ينقطع لهم الفتح والاستيلاء. سنة الله في خلقه.
الفصل الثامن
في أن عظم الدولة واتساع نطاقها..
وطول أمدها على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة والسبب في ذلك أن الملك إنما يكون بالعصبية. وأهل العصبية هم الحامية الذين ينزلون بممالك الدولة وأقطارها، وينقسمون عليها، فما كان من الدولة العامة قبيلها وأهل عصابتها أكثر، كانت أقوى وأكثر ممالك وأوطاناً، وكان ملكها أوسع لذلك.واعتبر ذلك بالدولة الإسلامية لما ألف الله كلمة العرب على الإسلام وكان عدد المسلمين في غزوة تبوك، آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مائة ألف وعشرة آلاف من مضر وقحطان، ما بين فارس وراجل، إلى من أسلم منهم بعد ذلك إلى الوفاة. فلما توجهو لطلب ما في أيدي الأمم من الملك لم يكن دونه حمى ولا وزر، فاستبيح حمى فارس والروم أهل الدولتين العظيمتين في العالم لعهدهم، والترك بالمشرق والإفرنجة والبربر بالمغرب، والقوط بالأندلس، وخطوا من الحجاز إلى السوس الأقصى، ومن اليمن إلى الترك بأقصى الشمال، واستولوا على الأقاليم السبعة.
ثم انظر بعد ذلك دولة صنهاجة والموحدين مع العبيديين قبلهم، لما كان قبيل كتامة القائمون بدولة العبيديين أكثر من صنهاجة ومن المصامدة، كانت دولتهم أعظم، فملكوا إفريقية والمغرب والشام ومصر والحجاز. ثم انظر بعد ذلك دولة زناتة لما كان عددهم أقل من المصامدة قصر ملكهم عن ملك الموحدين لقصور عددهم عن عدد المصامدة منذ أول أمرهم ثم اعتبر بعد ذلك حال الدولتين لهذا العهد لزناتة بني مرين وبني عبد الواد، لما كان عدد بني مرين لأول ملكهم أكثر من بني عبد الواد، كانت دولتهم أقوى منها وأوسع نطاقاً وكان لهم عليهم الغلب مرة بعد أخرى. يقال إن عدد بني مرين لأول ملكهم كان ثلاثة آلاف، وأن بني عبد الواد كانوا ألفاً، إلا أن الدولة بالرفه وكثرة التابع كثرت من أعدادهم.
وعلى هذه النسبة في أعداد المتغلبين لأول الملك يكون اتساع الدولة وقوتها.
وأما طول أمدها أيضاً فعلى تلك النسبة، لأن عمر الحادث من قوة مزاجه، ومزاج الدول إنما هو بالعصبية، فإذا كانت العصبية قوية كان المزاج تابعاً لها وكان أمد العمر طويلاً والعصبية إنما هي بكثرة العدد ووفوره كما قلناه. والسبب الصحيح في ذلك أن النقص إنما يبدو في الدولة من الأطراف، فإذا كانت ممالكها كثيرة كانت أطرافها بعيدة عن مركزها وكثيرة، وكل نقص يقع فلا بد له من زمن، فتكثر أزمان النقص لكثرة الممالك، واختصاص كل واحد منها بنقص وزمان فيكون أمدها طويلاً.
وانظر ذلك في دولة العرب الإسلامية كيف كان أمدها أطول الدول، لا بنو العباس أهل المركز ولا بنو أمية المستبدون بالأندلس. ولم ينقض أمر جميعهم إلا بعد الأربعمائة من الهجرة. ودولة العبيديين كان أمدها قريباً في مائتين وثمانين سنة. ودولة صنهاجة دونهم من لدن تقليد معز الدولة أمر إفريقية لبلكين بن زيري في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة، إلى حين استيلاء الموحدين على القلعة وبجاية سنة سبع وخمسين وخمسمائة.
الفصل التاسع
في أن الأوطان الكثيرة القبائل..
والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة والسبب في ذلك اختلاف الأراء والأهواء، وأن وراء كل رأي منها وهوى عصبية تمانع دونها، فيكثر الانتقاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت، وإن كانت ذات عصبية، لأن كل عصبية ممن تحت يدها تظن في نفسها منعة وقوة.وانظر ما وقع من ذلك بإفريقية والمغرب منذ أول الإسلام ولهذا العهد. فإن ساكن هذه الأوطان من البربر أهل قبائل وعصبيات، فلم يغن فيهم الغلب الأول الذي كان لابن أبي سرح عليهم وعلى الإفرنجة شيئاً. وعاودوا بعد ذلك الثورة والردة مرة بعد أخرى، وعظم الإثخان من المسلمين فيهم. ولما استقر الدين عندهم عادوا إلى الثورة والخروج والأخذ بدين الخوارج مرات عديدة.
قال ابن أبي زيد: ارتدت البرابرة بالمغرب اثنتي عشرة مرة. ولم تستقر كلمة الإسلام فيهم إلا لعهد ولاية موسى بن نصير فما بعده. وهذا معنى ماينقل عن عمران إفريقية مفرقة لقلوب أهلها، إشارة إلى ما فيها كثرة العصائب والقبائل الحاملة لهم على عدم الإذعان والانقياد. ولم يكن العراق لذلك العهد بتلك الصفة ولا الشام، إنما كانت حاميتها من فارس والروم، والكافة دهماء أهل مدن وأمصار. فلما غلبهم المسلمون على الأمر وانتزعوه من أيديهم لم يبق فيها ممانع ولا مشاق. والبربر قبائلهم بالمغرب أكثر من أن تحصى، وكلهم بادية وأهل عصائب وعشائر. وكلما هلكت قبيلة عادت الأخرى مكانها وإلى دينها من الخلاف والردة، فطال أمر العرب في تمهيد الدولة بوطن إفريقية والمغرب. وكذلك كان الأمر بالشام لعهد بني إسرائيل: كان فيه من قبائل فلسطين وكنعان وبني عيصو وبني مدين وبني لوط والروم واليونان والعمالقة وأكريكش، والنبط من جانب الجزيرة والموصل ما لا يحصى كثرة وتنوعاً في العصبية. فصعب على بني إسرائيل تمهيد دولتهم ورسوخ أمرهم واضطرب عليهم الملك مرة بعد أخرى. وسرى ذلك الخلاف إليهم فاختلفوا على سلطانهم وخرجوا عليه، ولم يكن لهم ملك موطد سائر أيامهم إلى أن غلبهم الفرس ثم يونان ثم الروم آخر أمرهم عند الجلاء. والله غالب على أمره.
وبعكس هذا أيضاً الأوطان الخالية من العصبيات يسهل تمهيد الدولة فيها، ويكون سلطانها وازعاً لقلة الهرج والانتقاض، ولا تحتاج فيها إلى كثير من العصبية، كما هو الشأن في مصر والشام لهذا العهد، إذ هي خلو من القبائل والعصبيات، كأن لم يكن الشام معدناً لهم كما قلناه. فملك مصر في غاية الدعة والرسوخ لقلة الخوارج وأهل العصائب، إنما هو سلطان ورعية، ودولتها قائمة بملوك الترك وعصائبهم يغلبون على الأمر واحداً بعد واحد، وينتقل الأمر فيهم من منبت إلى منبت، والخلافة مسماة للعباسي من أعقاب الخلفاء ببغداد.
وكذا شأن الأندلس لهذا العهد. فإن عصبية ابن الأحمر سلطانها لم تكن لأول دولتهم بقوية ولا كانت كرات، إنما يكون أهل بيت من بيوت العرب أهل الدولة الأموية بقوا، من ذلك، القلة وذلك أن أهل الأندلس لما انقرضت الدولة العربية منه وملكهم البربر من لمتونة والموحدين سئموا ملكتهم، وثقلت وطأتهم عليهم، فأشربت القلوب بغضاءهم، وأمكن الموحدون والسادة في آخر الدولة كثيراً من الحصون للطاغية في سبيل الاستظهار به على شأنهم، من تملك الحضرة مراكش. فاجتمع من كان بقي بها من أهل العصبية القديمة معادن من بيوت العرب، تجافى بهم المنبت عن الحاضرة والأمصار بعض الشيء، ورسخوا في العصبية مثل ابن هود وابن الأحمر وابن مردنيش وأمثالهم. فقام ابن هود بالأمر، ودعا بدعوة الخلافة العباسية بالمشرق، وحمل الناس على الخروج على الموحدين فنبذوا إليهم العهد وأخرجوهم، واستقل ابن هود بالأمر بالأندلس. ثم سما ابن الأحمر للأمر، وخالف ابن هود في دعوته، فدعا هؤلاء لابن أبي حفص صاحب إفريقية من الموحدين وقام بالأمر، وتناوله بعصابة قليلة من قرابته كانوا يسمون الرؤساء ولم يحتج لأكثر منهم لقلة العصائب بالأندلس، وأنها سلطان ورعية. ثم استظهر بعد ذلك على الطاغية بمن يجيز إليه البحر من أعياص زناتة، فصاروا معه عصبة على المثاغرة والرباط. ثم سما لصاحب المغرب من ملوك زنانة أمل في الاستيلاء على الأندلس، فصار أولئك الأعياص عصابة ابن الأحمر على الامتناع منه إلى أن تأثل أمره ورسخ، وألفته النفوس، وعجز الناس عن مطالبته وورثه أعقابه لهذا العهد. فلا تظن أنه بغير عصابة فليس كذلك، وقد كان مبدؤه بعصابة إلا أنها قليلة، وعلى قدر الحاجة، فإن قطر الأندلس لقلة العصائب والقبائل فيه يغني عن كثرة العصبية فى التغلب عليهم. والله غني عن العالمين.
الفصل العاشر
في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد
وذلك أن الملك كما قدمناه إنما هو بالعصبية، والعصبية متألفة من عصبات كثيرة تكون واحدة منها أقوى من الأخرى كلها فتغلبها وتستولي عليها، حتى تصيرها جميعاً في ضمنها، وبذلك يكون الاجتماع والغلب على الناس والدول. وسره أن العصبية العامة للقبيل هي مثل المزاج للمتكون، والمزاج إنما يكون عن العناصر، وقد تبين في موضعه أن العناصر إذا اجتمعت متكافئة فلا يقع منها مزاج أصلاً، بل لا بد أن تكون واحدة منها هي الغالبة على الكل حتى تجمعها وتؤلفها وتصيرها عصبية واحدة شاملة لجميع العصائب، وهي موجودة في ضمنها. وتلك العصبية الكبرى إنما تكون لقوم أهل بيت ورياسة فيهم، ولا بد أن يكون واحد منهم رئيساً لهم غالباً عليهم، فيتعين رئيساً للعصبيات كلها لغلب منبته لجميعها. وإذا تعين له ذلك فمن الطبيعة الحيوانية خلق الكبر والأنفة ة فيأخذ حينئذ من المساهمة والمشاركة في استتباعهم والتحكم فيهم، ويجيء خلق التأله الذي في طباع البشر مع ما تقتضيه السياسة من انفراد الحاكم، لفساد الكل باختلاف الحكام: " لو كان فيهما آلهة إلا اللة لفسدتا " . فتجدع حينئذ أنوف العصبيات وتفلج شكائمهم عن أن يسموا إلى مشاركته في التحكم، وتقرع عصبيتهم عن ذلك، وينفرد به ما استطاع، حتى لا يترك لأحد منهم في الأمر لا ناقة ولا جملاً. فينفرد بذلك المجد بكليته ويدفعهم عن مساهمته. وقد يتم ذلك للأول من ملوك الدولة، وقد لا يتم إلا للثاني والثالث على قدر ممانعة العصبيات وقوتها. إلا أنه أمر لا بد منه في الدول. " سنة الله التي قد خلت في عباده " ، والله تعالى أعلم.الفصل الحادي عشر
في أن من طبيعة الملك الترف
وذلك أن الأمة إذا تغلبت وملكت ما بأيدي أهل الملك قبلها كثر رياشها ونعمتها فتكثر عوائدهم، ويتجاوزون ضرورات العيش وخشونته إلى نوافله ورقته وزينته. ويذهبون إلى اتباع من قبلهم في عوائدهم وأحوالهم، وتصير لتلك النوافل عوائد ضرورية في تحصيلها، وينزعون مع ذلك إلى رقة الأحوال في المطاعم والملابس والفرش والأنية، ويتفاخرون في ذلك ويفاخرون فيه غيرهم من الأمم، في أكل الطيب ولبس الأنيق وركوب الفاره، ويناغي خلفهم في ذلك سلفهم إلى آخر الدولة. وعلى قدر ملكهم يكون حظهم من ذلك، وترفهم فيه، إلى أن يبلغوا من ذلك الغاية التي للدولة أن تبلغها بحسب قوتها وعوائد من قبلها. سنة الله في خلقه والله تعالى أعلم.الفصل الثاني عشر
في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون
وذلك أن الأمة لا يحصل لها الملك إلا بالمطالبة، والمطالبة غايتها الغلب والملك، وإذا حصلت الغاية انقضى السعي إليها. قال الشاعر:عجبت لسعي الدهر بيني وبينها ... فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر
فإذا حصل الملك أقصروا عن المتاعب التي كانوا يتكلفونها في طلبه وآثروا الراحة والسكون والدعة، ورجعوا إلى تحصيل ثمرات الملك من المباني والمساكن والملابس، فيبنون القصور، ويجرون المياه، ويغرسون الرياض، ويستمتعون بأحوال الدنيا، ويؤثرون الراحة على المتاعب، ويتأنقون في أحوال الملابس والمطاعم والأنية والفرش ما استطاعوا، ويألفون ذلك ويورثونه من بعدهم من أجيالهم. ولا يزال ذلك يتزايد فيهم إلى أن يتأذن الله بأمره، وهو خير الحاكمين، والله تعالى أعلم.
الفصل الثالث عشر
في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك..
من الانفراد بالمجد وحصول الترف والدعة أقبلت الدولة على الهرم وبيانه من وجوه: الأول أنها تقتضي الانفراد بالمجد كما قلناه. وما كان المجد مشتركاً بين العصابة وكان سعيهم له واحداً، كانت هممهم في التغلب على الغير والذب عن الحوزة أسوة في طموحها وقوة شكائمها، ومرماهم إلى العز جميعاً، وهم يستطيبون الموت في بناء مجدهم ويؤثرون الهلكة على فساده. وإذا انفرد الواحد منهم بالمجد قرع عصبيتهم وكبح من أعنتهم، واستأثر بالأموال دونهم، فتكاسلوا عن الغزو وفشل ريحهم ورئموا المذلة والاستعباد. ثم ربي الجيل الثاني منهم على ذلك، يحسبون ما ينالهم من العطاء أجراً من السلطان لهم على الحماية والمعونة، لا يجري في عقولهم سواه، وقل أن يستأجر أحد نفسه على الموت، فيصير ذلك وهناً في الدولة وخضداً من الشوكة، وتقبل به على مناحي الضعف والهرم لفساد العصبية بذهاب البأس من أهلها.والوجه الثاني أن طبيعة الملك تقتضي الترف كما قدمناه، فتكثر عوائدهم وتزيد نفقاتهم على أعطياتهم، ولا يفي دخلهم بخرجهم، فالفقير منهم يهلك والمترف يستغرق عطاءه بترفه، ثم يزداد ذلك في أجيالهم المتأخرة إلى أن يقصر العطاء كله عن الترف وعوائده، وتمسهم الحاجة وتطالبهم ملوكهم بحصر نفقاتهم في الغزو والحروب، فلا يجدون وليجة عنها، فيوقعون بهم العقوبات، وينتزعون ما في أيدي الكثير منهم يستأثرون به عليهم، أو يؤثرون به أبناءهم وصنائع دولتهم، فيضعفونهم لذلك عن إقامة أحوالهم، ويضعف صاحب الدولة بضعفهم. وأيضاً إذا كثر الترف في الدولة وصار عطاؤهم مقصراً عن حاجاتهم ونفقاتهم، احتاج صاحب الدولة الذي هو السلطان إلى الزيادة في أعطياتهم حتى يسد خللهم ويزيح عللهم. والجباية مقدارها معلوم، ولا تزيد ولا تنقص وإن زادت بما يستحدث من المكوس فيصير مقدارها بعد الزيادة محدوداً. فإذا وزعت الجباية على الأعطيات وقد حدثت فيها الزيادة لكل واحد بما حدث من ترفهم وكثرة نفقاتهم، نقص عدد الحامية حينئذ عما كان قبل زيادة الأعطيات. ثم يعظم الترف وتكثر مقادير الأعطيات لذلك، فينقص عدد الحامية، وثالثاً ورابعاً إلى أن يعود العسكر إلى أقل الأعداد، فتضعف الحماية لذلك، وتسقط قوة الدولة ويتجاسر عليها من يجاورها من الدول أو من هو تحت يديها من القبائل والعصائب، ويأذن الله فيها بالفناء الذي كتبه على خليقته. وأيضاً فالترف مفسد للخلق بما يحصل في النفس من ألوان الشر والسفسفة وعوائدها كما يأتي في فصل الحضارة، فتذهب منهم خلال الخير التي كانت علامة على الملك ودليلاً عليه، ويتصفون بما يناقضها من خلال الشر، فتكون علامة على الأدبار والانقراض بما جعل الله من ذلك في خليقته، وتأخذ الدولة مبادىء العطب وتتضعضع أحوالها وتنزل بها أمراض مزمنة من الهرم إلى أن يقضى عليها.
الوجه الثالث: أن طبيعة الملك تقتضي الدعة كما ذكرناه، وإذا اتخذوا الدعة والراحة مألفاً وخلقاً صار لهم ذلك طبيعة وجبلة شأن العوائد كلها وإيلافها، فتربى أجيالهم الحادثة في غضارة العيش ومهاد الترف والدعة، وينقلب خلق التوحش وينسون عوائد البداوة التي كان بها الملك من شدة البأس، وتعود الافتراس وركوب البيداء وهداية القفر. فلا يفرق بينهم وبين السوقة من الحضر إلا في الثقافة والشارة فتضعف حمايتهم ويذهب بأسهم وتنخضد شوكتهم ويعود وبال ذلك على الدولة بما تلبس به من ثياب الهرم. ثم لا يزالون يتلونون بعوائد الترف والحضارة والسكون والدعة ورقة الحاشية في جميع أحوالهم، وينغمسون فيها، وهم في ذلك يبعدون عن البداوة والخشونة، وينسلخون عنها شيئاً فشيئاً، وينسون خلق البسالة التي كانت بها الحماية والمدافعة، حتى يعودوا عيالاً على حامية اخرى إن كانت لهم. واعتبر ذلك في الدول التي أخبارها في الصحف لديك تجد ما قلته لك من ذلك صحيحاً من غير ريبة.
وربما يحدث في الدولة، إذا طرقها هذا الهرم بالترف والراحة، أن يتخير صاحب الدولة أنصاراً وشيعة من غير جلدتهم ممن تعود الخشونة فيتخذهم جنداً يكون أصبر على الحرب وأقدر على معاناة الشدائد من الجوع والشظف، ويكون ذلك دواء للدولة من الهرم الذي عساه أن يطرقها حتى يأذن الله فيها بأمره. وهذا كما وقع في دولة الترك بالمشرق، فأبى غالب جندها الموالي من الترك. فتتخير ملوكهم من أولئك المماليك المجلوبين إليهم فرساناً وجنداً، فيكونون أجراً على الحرب وأصبر على الشظف من أبناء الملوك الذين كانوا قبلهم وربوا في ماء النعيم والسلطان وظله وكذلك في دولة الموحدين بإفريقية، فإن صاحبها كثيراً ما يتخذ أجناده من زناتة والعرب ويستكثر منهم، ويترك أهل الدولة المتعودين للترف فتستجد الدولة بذلك عمراً آخر سالماً من الهرم. والله وارث الأرض ومن عليها.
الفصل الرابع عشر
في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص
اعلم أن العمر الطبيعي للأشخاص على ما زعم الأطباء والمنجمون مائة وعشرون سنة، وهي سنة القمر الكبرى عند المنجمين. ويختلف العمر في كل جيل بحسب القرانات، فيزيد عن هذا وينقص منه، فتكون أعمار بعض أهل القرانات مائة تامة وبعضهم خمسين أو ثمانين أو سبعين على ما تقتضيه أدلة القرانات عند الناظرين فيها. وأعمار هذه الملة ما بين الستين إلى السبعين كما في الحديث. ولا يزيد على العمر الطبيعي الذي هو مائة وعشرون إلا في الصور النادرة وعلى الأوضاع الغريبة من الفلك كما وقع في شأن نوح عليه السلام، وقليل من قوم عاد وثمود. وأما أعمار الدول أيضاً وإن كانت تختلف بحسب القرانات، إلا أن الدولة في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال. والجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط، فيكون أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلى غايته. قال تعالى: " حتى إذ ا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة " . ولهذا قلنا أن عمر الشخص الواحد هو عمر الجيل. ويؤيده ما ذكرناه في حكمة التيه الذي وقع في بني إسرائيل، وأن المقصود بالأربعين فيه فناء الجيل الأحياء ونشأة جيل آخر لم يعهدوا الذل ولا عرفوه، فدل على اعتبار الأربعين في عمر الجيل الذي هو عمر الشخص الواحد.وإنما قلنا أن عمر الدولة لا يعدو في الغالب ثلاثة أجيال: لأن الجيل الأول لم يزالوا على خلق البداوة وخشونتها وتوحشها من شظف العيش والبسالة والافتراس والاشتراك في المجد، فلا تزال بذلك سورة العصبية محفوظة فيهم، فحدهم مرهف، وجانبهم مرهوب، والناس لهم مغلوبون.
والجيل الثاني تحول حالهم بالملك والترفه من البداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف والخصب، ومن الأشتراك في المجد إلى انفراد الواحد به، وكسل الباقين عن السعي فيه، ومن عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة، فتنكسر سورة العصبية بعض الشيء، وتؤنس منهم المهانة والخضوع. ويبقى لهم الكثير من ذلك، بما أدركوا الجيل الأول وباشروا أحوالهم وشاهدوا من اعتزازهم وسعيهم إلى المجد ومراميهم في المدافعة والحماية، فلا يسعهم ترك ذلك بالكلية، وإن ذهب منه ما ذهب، ويكونون على رجاء من مراجعة الأحوال التي كانت للجيل الأول، أو على ظن من وجودها فيهم.
وأما الجيل الثالث فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن، ويفقدون حلاوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر ويبلغ فيهم الترف غايته بما تفنقوه من النعيم وغضارة العيش، فيصيرون عيالاً على الدولة، ومن جملة النساء والولدان المحتاجين للمدافعة عنهم، وتسقط العصبية بالجملة، وينسون الحماية والمدافعة والمطالبة، وينسون على الناس في الشارة والزي وركوب الخيل وحسن الثقافة يموهون بها، وهم في الأكثر أجبن من النسوان على ظهورها. فإذا جاء المطالب لهم لم يقاوموا مدافعته، فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة، ويستكثر بالموالي، ويصطنع من يغني عن الدولة بعض الغناء، حتى يتأذن بانقراضها، فتذهب الدولة بما حملت. فهذه كما تراه ثلاثة أجيال فيها يكون هرم الدولة وتخلفها.
ولهذا كان انقراض الحسب في الجيل الرابع كما مر في أن المجد والحسب إنما هو في أربعة آباء. وقد أتيناك فيه ببرهان طبيعي كاف ظاهر مبني على ما مهدناه قبل من المقدمات، فتأمله فلن تعدو وجه الحق إن كنت من أهل الأنصاف.
وهذه الأجيال الثلاثة عمرها مائة وعشرون سنة على ما مر. ولا تعدو الدول في الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعده، إلا أن عرض لها عارض آخر من فقدان المطالب، فيكون الهرم حاصلاً مستولياً والطالب لم يخضرها، ولو قد جاء الطالب لما وجد مدافعاً " فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " .
فهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من التزيد إلى سن الوقوف، ثم إلى سن الرجوع. ولهذا يجري على ألسنة الناس في المشهور أن عمر الدولة مائة سنة، وهذا معناه. فاعتبره واتخذ منه قانوناً يصحح لك عدد الأباء في عمود النسب الذي تريده من قبل معرفة السنين الماضية إذا كنت قد استرب في عددهم، وكانت السنون الماضية منذ أولهم محصلة لديك فعد لكل مائة من السنين ثلاثة من الأباء، فإن نفدت على هذا القياس مع نفود عددهم فهو صحيح، وإن نقصت عنه بجيل فقد غلط عددهم بزيادة واحد في عمود النسب، وإن زادت بمثله فقد سقط واحد. وكذلك تأخذ عدد السنين من عددهم إذا كان محصلاً لديك، فتأمله تجده في الغالب صحيحاً. " والله يقدر الليل والنهار " .
الفصل الخامس عشر
في انتقال الدولة من البداوة إلي الحضارة
اعلم أن هذه الأطوار طبيعية للدول. فإن الغلب الذي يكون به الملك إنما هو بالعصبية وبما يتبعها من شدة البأس وتعود الافتراس، ولا يكون ذلك غالباً إلا مع البداوة، فطور الدولة من أولها بداوة. ثم إذا حصل الملك تبعه الرفه واتساع الأحوال، والحضارة إنما هي تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله، فلكل واحد منها صنائع في استجادته والتأنق فيه تختص به ويتلو بعضها بعضاً، وتتكثر باختلاف ما تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم بأحوال الترف، وما تتلون به من العوائد. فصار طور الحضارة في الفلك يتبع طور البداوة ضرورة، لضرورة تبعية الرفه للملك.وأهل الدول أبداً يقلدون في طور الحضارة وأحوالها للدولة السابقة قبلهم. فأحوالهم يشاهدون، ومنهم في الغالب يأخذون، ومثل هذا وقع للعرب لما كان الفتح وملكوا فارس والروم واستخدموا بناتهم وأبناءهم، ولم يكونوا لذلك العهد في شيء من الحضارة. فقد حكي أنه قدم لهم المرقق فكانوا يحسبونه رقاعاً، وعثروا على الكافور في خزائن كسرى فاستعملوه في عجينهم ملحاً، وأمثال ذلك.
فلما استعبدوا أهل الدول قبلهم واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازلهم واختاروا منهم المهرة في أمثال ذلك والقومة عليهم أفادوهم علاج ذلك، والقيام على عمله، والتفنن فيه، مع ما حصل لهم من اتساع العيش والتفنن في أحواله، فبلغوا الغاية في ذلك، وتطوروا بطور الحضارة والترف في الأحوال، واستجادة المطاعم والمشارب والملابس والمباني والأسلحة والفرش والآنية وسائر الماعون والخرثي، وكذلك أحوالهم في أيام المباهاة والولائم وليالي الأعراس، فأتوا من ذلك وراء الغاية، وانظر ما نقله المسعودي والطبري وغيرهما في إعراس المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل، وما بذل أبوها لحاشية المأمون حين وافاه في خطبتها إلى داره بفم الصلح، وركب إليها في السفين، وما أنفق في إملاكها، وما نحلها المأمون وأنفق في عرسها، تقف من ذلك على العجب. فمنه أن الحسن بن سهل نثر يوم الأملاك في الصنيع الذي حضره حاشية المأمون، فنثر على الطبقة الأولى منهم بنادق المسك ملتوتة على الرقاع بالضياع والعقار، مسوغة لمن حصلت في يده، يقع لكل واحد منهم ما أداه إليه الاتفاق والبخت وفرق على الطبقة الثانية بدر الدنانير في كل بدرة عشرة ألاف، وفرق على الطبقة الثالثة بدر الدراهم كذلك، بعد أن أنفق في مقامة المأمون بداره أضعاف ذلك. ومنه أن المامون أعطاها في مهرها ليلة زفافها ألف حصاة من الياقوت، وأوقد شموع العنبر في كل واحدة مائة من وهو رطل وثلثان وبسط لها فرشاً كان الحصير منها منسوجاً بالذهب مكللاً بالدر والياقوت. وقال المأمون حين رآه: " قاتل الله أبا نواس، كأنه أبصر هذا حيث يقول في صفة الخمر:
كأن صغرى وكبرى من فواقعها ... حصباء در على أرض من الذهب
وأعد بدار الطبخ من الحطب لليلة الوليمة نقل مائة وأربعين بغلاً مدة عام كامل ثلاث مرات كل يوم. وفني الحطب لليلتين، وأوقدوا الجريد يصبون عليه الزيت. وأوعز إلى النواتية بإحضار السفن لإجازة الخواص من الناس بدجلة من بغداد إلى قصور الملك بمدينة المأمون لحضور الوليمة، فكانت الحراقات المعدة لذلك ثلاثين ألفاً، أجازوا الناس فيها أخريات نهارهم. وكثير من هذا وأمثاله. وكذلك عرس المامون بن ذي النون بطليطلة، نقله ابن بسام في كتاب الذخيرة وابن حبان بعد أن كانوا كلهم في الطور الأول من البداوة عاجزين عن ذلك جملة، لفقدان أسبابه والقائمين على صنائعه في غضاضتهم وسذاجتهم.
ويذكر أن الحجاج أولم في اختتان بعض ولده فاستحضر بعض الدهاقين يسأله عن ولائم الفرس، وقال: أخبرني بأعظم صنيع شهدته، فقال له: نعم أيها الأمير، شهدث بعض مرازبة كسرى، وقد صنع لأهل فارس صنيعاً أحضر فيه صحاف الذهب على أخونة الفضة، أربعاً على كل واحد، وتحمله أربع وصائف، ويجلس عليه أربعة من الناس، فإذا طعموا أتبعوا أربعتهم المائدة بصحافها ووصائفها. فقال الحجاج: يا غلام انحر الجزر وأطعم الناس. وعلم انه لا يستقل بهذه الأبهة. وكذلك كان.
ومن هذا الباب أعطية بني أمية وجوائزهم. فإنما كان أكثرها الإبل أخذاً بمذاهب العرب وبداوتهم. ثم كانت الجوائز في دولة بني العباس والعبيديين من بعدهم ما علمت من أحمال المال وتخوت الثياب وإعداد الخيل بمراكبها.
وهكذا كان شأن كتامة مع الأغالبة بإفريقية، وكذا بنو طغج بمصر، وشأن لمتونة مع ملوك الطوائف بالأندلس، والموحدين كذلك وشأن زناتة مع الموحدين وهلم جرا، تنتقل الحضارة من الدول السالفة إلى الدول الخالفة: فانتقلت حضارة الفرس للعرب بني أمية وبني العباس، وانتقلت حضارة بني أمية بالأندلس إلى ملوك المغرب من الموحدين وزناتة لهذا العهد، وانتقلت حضارة بني العباس إلى الديلم ثم إلى الترك، ثم إلى السلجوقية، ثم إلى الترك المماليك بمصر، والتتر بالعراقين. وعلى قدر عظم الدولة يكون شأنها في الحضارة، إذ أمور الحضارة من توابع الترف، والترف من توابع الثروة والنعمة، والثروة والنعمة من توابع الملك، ومقدار ما يستولي عليه أهل الدولة. فعلى نسبة الملك يكون ذلك كله. فاعتبره وتفهمه وتأمله تجده صحيحاً في العمران. " والله وارث الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين " .
الفصل السادس عشرفي أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها
والسبب في ذلك أن القبيل إذا حصل لهم الملك والترف كثر التناسل والولد والعمومية، فكثرت العصابة، واستكثروا أيضاً من الموالي والصنائع، وربيت أجيالهم في جو ذلك النعيم والرفه، فازدادوا بهم عدداً إلى عددهم وقوة إلى قوتهم بسبب كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد. فإذا ذهب الجيل الأول والثاني وأخذت الدولة في الهرم لم تستقل أولئك الصنائع والموالي بأنفسهم في تأسيس الدولة وتمهيد ملكها، لأنهم ليس لهم من الأمر شيء، إنما كانوا عيالاً على أهلها ومعونة لها، فإذا ذهب الأصل لم يستقل الفرع بالرسوخ فيذهب ويتلاشى، ولا تبقى الدولة على حالها من القوة.
واعتبر هذا بما وقع في الدولة العربية في الإسلام. كان عدد العرب كما قلناه لعهد النبوة والخلافة مائة وخمسين ألفاً أو ما يقاربها من مضر وقحطان، ولما بلغ الترف مبالغه في الدولة وتوفر نموهم بتوفر النعمة، واستكثر الخلفاء من الموالي والصنائع، بلغ ذلك العدد إلى أضعافه. يقال: أن المعتصم نازل عمورية لما افتتحها في تسعمائة ألف. ولا يبعد مثل هذا العدد أن يكون صحيحاً إذا اعتبرت حاميتهم في الثغور الدانية والقاصية شرقاً وغرباً إلى الجند الحاملين سرير الملك والموالي والمصطنعين. وقال المسعودي: أحصي بنو العباس بن عبد المطلب خاصة أيام المأمون للإنفاق عليهم، فكانوا ثلاثين ألفاً بين ذكران وإناث، فانظر مبالغ هذا العدد لأقل من مئتي سنة، واعلم أن سببه إلى الرفه والنعيم الذي حصل للدولة وربي فيه أجيالهم، وإلا فعدد العرب لأول الفتح لم يبلغ هذا ولا قريباً منه. والله الخلاق العليم.
الفصل السابع عشر
في أطوار الدولة واختلاف أحوالها
وخلق أهلها باختلاف الأطوار اعلم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة، ويكتسب القائمون بها في كل طور خلقاً من أحوال ذلك الطورلا يكون مثلة في الطور الأخر، لأن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه. وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب خمسة أطوار: الطور الأول: طور الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانع، والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلها. فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية، لا ينفرد دونهم بشيء لأن ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد بحالها.الطور الثاني: طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة. ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنياً باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع، والاستكثار من ذلك لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نسبه، الضاربين في الملك بمثل سهمه. فهو يدافعهم عن الأمر ويصدهم عن موارده ويردهم على أعقابهم، أن يخلصوا إليه، حتى يقر الأمر في نصابه، ويفرد أهل بيته بما يبني من مجده، فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه الأولون في طلب الأمر أو أشد، لأن الأولين دافعوا الأجانب فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العصبية بأجمعهم، وهذا يدافع الأقارب لا يظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من الأباعد، فيركب صعباً من الأمر.
الطور الثالث: طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الأثار وبعد الصيت، فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخرج وإحصاء النفقات والقصد فيها، وتشييد المباني الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل المرتفعة، وإجازة الوفود من أشراف الأمم ووجوه القبائل وبث المعروف في أهله، هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمال والجاه، واعتراض جنوده وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال، حتى يظهر أثر ذلك عليهم في ملابسهم وشكتهم وشاراتهم يوم الزينة، فيباهي بهم الدول المسالمة، ويرهب الدول المحاربة. وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد من أصحاب الدولة. لأنهم في هذه الأطوار كلها مستقلون بآرائهم، بانون لعزهم، موضحون الطرق لمن بعدهم.
الطور الرابع: طور القنوع والمسالمة. ويكون صاحب الدولة في هذا قانعاً بما بنى أولوه، سلماً لأنظاره من الملوك وأقتاله، مقلداً للماضين من سلفه، فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل، ويقتفي طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء، ويرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمره وأنهم أبصر بما بنوا من مجده.
الطور الخامس: طور الإسراف والتبذير. ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفاً لما جمع أولوه في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفي مجالسه، واصطناع أخدان السوء وخضراء الدمن، وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستلفون بحملها، ولا يعرفون ما يأتون ويذرون منها، مستفسداً لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفه، حتى يضطغنوا عليه، ويتخاذلوا عن نصرته، مضيعاً من جنده بما أنفق من أعطياتهم في شهواته، وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده، فيكون مخرباً لما كان سلفه يؤسسون، وهادماً لما كانوا يبنون، وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم، ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخفص منه، ولا يكون لها معه برء، إلى أن تنقرض كما نبينه في الأحوال التي نسردها. والله خير الوارثين.
؟
الفصل الثامن عشر
في أن أثار الدولة كلها..
علي نسبة قوتها في أصلها والسبب في ذلك أن الأثار إنما تحدث عن القوة التي بها كانت أولاً وعلى قدرها يكون الأثر. فمن ذلك مباني الدولة وهياكلها العظيمة. فإنما تكون على نسبة قوة الدولة في أصلها، لأنها لا تتم إلا بكثرة الفعلة واجتماع الأيدي على العمل والتعاون فيه. فإذا كانت الدولة عظيمة فسيحة الجوانب كثيرة الممالك والرعايا، كان الفعلة كثيرين جداً وحشروا من آفاق الدولة وأقطارها، فتم العمل على أعظم هياكله.ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وثمود وما قصه القرآن عنهما. وانظر بالمشاهدة إيوان كسرى وما اقتدر فيه الفرس حتى إنه عزم الرشيد على هدمه وتخريبه فتكاءد عنه، وشرع فيه ثم أدركة العجز، وقصة استشارته ليحيى بن خالد في شأنه معروفة. فانظر كيف تقتدر دولة على بناء لاتستطيع أخرى على هدمه هع بون ما بين الهدم والبناء في السهولة تعرف من ذلك بون ما بين الدولتين. وانظر إلى بلاط الوليد بدمشق وجامع بني أمية بقرطبة والقنطرة التي على واديها، وكذلك بناء الحنايا لجلب الماء إلى قرطاجنة في القناة الراكبة عليها، وآثار شرشال بالمغرب والأهرام بمصر وكثير من هذه الأثار الماثلة للعيان، تعلم منه اختلاف الدول في القوة والضعف.
واعلم أن تلك الأفعال للأقدمين إنما كانت بالهندام واجتماع الفعلة وكثرة الأيدي عليها، فبذلك شيدت تلك الهياكل والمصانع. ولا تتوهم ما تتوهمه العامة أن ذلك لعظم أجسام الأقدمين عن أجسامنا في أطرافها وأقطارها، فليس بين البشر في ذلك كبير بون كما تجد بين الهياكل والآثار. ولقد ولع القصاص بذلك وتغالوا فيه، وسطروا عن عاد وثمود والعمالقة في ذلك أخباراً عريقة في الكذب، من أغربها ما يحكون عن عوج بن عناق رجل من العمالقة الذين قاتلهم بنو إسرائيل في الشام، زعموا أنه كان لطوله يتناول السمك من البحر ويشويه إلى الشمس. ويزيدون إلى جهلهم بأحوال البشر الجهل بأحوال الكواكب لما اعتقدوا أن للشمس حرارة وإنها شديدة فيما قرب منها، ولا يعلمون أن الحر هو الضوء، وأن الضوء فيما قرب من الأرض أكثر لانعكاس الأشعة من سطح الأرض بمقابلة الأضواء، فتتضاعف الحرارة هنا لأجل ذلك، وإذا تجاوزت مطارح الأشعة المنعكسة فلا حر هنالك، بل يكون فيه البرد حيث مجاري السحاب، وأن الشمس في نفسها لا حارة ولا باردة وإنما هي جسم بسيط مضيء لا مزاج له. وكذلك عوج بن عناق هو فيما ذكروه من العمالقة أو من الكنعانيين الذين كانوا فريسة بني إسرائيل عند فتحهم الشام، وأطوال بني إسرائيل وجسمانهم لذلك العهد قريبة من هياكلنا. يشهد لذلك أبواب بيت المقدس، فإنها وإن خربت وجددت لم تزل محافظة على أشكالها ومقادير أبوابها. وكيف يكون التفاوت بين عوج وبين أهل عصره بهذا المقدار. وإنما مثار غلطهم في هذا أنهم استعظموا آثار الأمم ولم يفهموا حال الدول في الاجتماع والتعاون، وما يحصل بذلك وبالهندام من الأثار العظيمة، فصرفوه إلى قوة الأجسام وشدتها بعظم هياكلها، وليس الأمر كذلك.
وقد زعم المسعودي ونقله عن الفلاسفة مزعماً لا مستند له إلا التحكم، وهو أن الطبيعة التي هي جبلة للأجسام، لما برأ الله الخلق كانت في تمام المرة ونهاية القوة والكمال، وكانت الأعمار أطول والأجسام أقوى لكمال تلك الطبيعة، فإن طروء الموت إنما هو بانحلال القوى الطبيعية، فإذا كانت قوية كانت الأعمار أزيد. فكان العالم في أولية نشأته تام الأعمار كامل الأجسام، ثم لم يزل يتناقص لنقصان المادة إلى أن بلغ إلى هذه الحال التي هو عليها، ثم لا يزال يتناقص إلى وقت الانحلال وانقراض العالم وهذا رأي لا وجه له إلا التحكم كما تراه، وليس له علة طبيعية ولا سبب برهاني. ونحن نشاهد مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البنيان والهياكل والديار والمساكن، كديار ثمود المنحوتة في الصلد من الصخر، بيوتاً صغاراً وأبوابها ضيقة. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنها ديارهم، ونهى عن استعمال مياههم وطرح ما عجن به وأهرقه وقال: " لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم " . وكذلك أرض عاد ومصر والشام وسائر بقاع الأرض شرقاً وغرباً. والحق ما قررناه.
ومن آثار الدول أيضاً حالها في الأعراس والولائم كما ذكرناه في وليمة بوران وصنيع الحجاج وابن ذي النون، وقد مر ذلك كله.
ومن آثارها أيضاً عطايا الدول وأنها تكون على نسبتها. ويظهر ذلك فيها ولو أشرفت على الهرم، فإن الهمم التي لأهل الدولة تتكون على نسبة قوة ملكهم وغلبهم للناس، والهمم لا تزال مصاحبة لهم إلى انقراض الدولة. واعتبر ذلك بجوائز ابن ذي يزن لوفد قريش، كيف أعطاهم من أرطال الذهب والفضة والأعبد والوصائف عشراً عشراً، ومن كرش العنبر واحدة، وأضعف ذلك بعشرة أمثاله لعبد المطلب، وإنما ملكه يومئذ قرارة اليمن خاصة تحت استبداد فارس، وإنما حملة على ذلك همة نفسه بما كان لقومه التبابعة من الملك في الأرض والغلب على الأمم في العراقين والهند والمغرب. وكان الصنهاجيون بإفريقية أيضاً إذا أجازوا الوفد من أمراء زناتة الوافدين عليهم، فإنما يعطونهم المال أحمالاً والكساء تخوتاً مملوءة، والحملان نجائب عديدة. وفي تاريخ ابن الرقيق من ذلك أخبار كثيرة. وكذلك كان عطاء البرامكة وجوائزهم ونفقاتهم، وكانوا إذا كسبوا معدماً فإنما هو الولاية والنعمة آخر الدهر لا العطاء الذي يستنفده يوم أو بعض يوم. وأخبارهم في ذلك كثيرة مسطورة وهي كلها على نسبة الدول جارية. هذا جوهر الصقلي الكاتب قائد جيش العبيديين لما ارتحل إلى فتح مصر استعد من القيروان بألف حمل من المال. ولا تنتهى اليوم دولة إلى مثل هذا.
موارد بيت المال ببغداد أيام المأمونوكذلك وجد بخط أحمد بن محمد بن عبد الحميد عمل بما يحمل إلى بيت المال ببغداد أيام المأمون من جميع النواحي، نقلته من جراب الدولة: غلات السواد سبع وعشرون ألف ألف درهم مرتين، وثمانمائة ألف درهم، ومن الحلل النجرانية مائتا حلة ومن طين الختم مائتان وأربعون رطلاً.
كنكر: أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وستمائة ألف درهم.
كوردجلة: عشرون ألف ألف درهم وثمانمائة درهم.
حلوان: أربعة آلاف ألف درهم مرتين، وثمانمائة ألف درهم.
الأهواز: خمسة وعشرون ألف درهم مرة، ومن السكر ثلاثون ألف رطل.
فارس: سبعة وعشرون ألف ألف درهم، ومن ماء الورد ثلاثون ألف قارورة، ومن الزيت الأسود عشرون ألف رطل.
كرمان أربعة ألاف ألف درهم مرتين ومائتا ألف درهم، ومن المتاع اليماني الخمسمائة ثوب، ومن التمر عشرون ألف رطل.
مكران: أربعمائة ألف درهم مرة.
السند وما يليه: أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وخمسمائة ألف درهم، ومن العود الهندي مائة وخمسون رطلاً.
سجستان: أربعة ألاف ألف درهم مرتين، ومن الثياب المعينة ثلاثمائة ثوب، ومن الفانيد عشرون رطلاً.
خراسان: ثمانية وعشرون ألف ألف درهم مرتين، ومن نقر الفضة ألفا نقرة، ومن البراذين أربعة ألاف، ومن الرقيق ألف رأس، ومن المتاع عشرون ألف ثوب، ومن الأهليلج ثلاثون ألف رطل.
جرجان: اثنا عشر ألف ألف درهم مرتين، ومن الأبريسم ألف شقة.
قومس: ألف ألف درهم مرتين وخمسمائة ألف من نقر الفضة.
طبرستان والربان ونهاوند: ستة ألاف ألف مرتين وثلاثمائة ألف، ومن الفرش الطبري ستمائة قطعة، ومن الأكسية مائتان، ومن الثياب خمسمائة ثوب، ومن المناديل ثلاثمائة، ومن الجامات ثلاثمائة.
الري: اثنا عشر ألف ألف درهم مرتين، ومن العسل عشرون ألف رطل.
همدان: أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وثلاثمائة ألف، ومن رب الرمان ألف رطل ومن العسل اثنا عشر ألف رطل.
ما بين البصرة والكوفة: عشرة ألف ألف درهم مرتين وسبعمائة ألف درهم.
ماسبذان والدينار: أربعة ألاف ألف درهم مرتين.
شهرزور: ستة ألاف ألف درهم مرتين وسبعمائة ألف درهم.
الموصل وما إليها: أربعة وعشرون ألف ألف درهم مرتين، ومن العسل الأبيض عشرون ألف ألف رطل.
أذربيجان: أربعة ألاف ألف درهم مرتين.
الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات: أربعة وثلاثون ألف ألف درهم مرتين، ومن الرقيق ألف رأس، ومن العسل اثنا عشر ألف زق، ومن البزاة عشرة، ومن الأكسية عشرون.
أرمينية: ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتين ومن القسط المحفور عشرون، ومن الزقم خمسمائة وثلاثون رطلاً، ومن المسايج السور ماهي عشرة ألاف رطل، ومن الصونج عشرة آلاف رطل، ومن البغال مائتان ومن المهرة ثلاثون.
قنسرين: أربعمائة ألف دينار، ومن الزيت ألف حمل.
دمشق: أربعمائة ألف دينار وعشرون ألف دينار.
الأردن: سبعة وتسعون ألف دينار.
فلسطين: ثلاثمائة ألف دينار وعشرة ألاف دينار، ومن الزيت ثلاثمائة ألف رطل.
مصر: ألف ألف دينار وتسعمائة ألف دينار وعشرون ألف دينار.
برقة: ألف ألف درهم مرتين.
إفريقية: ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتين، ومن البسط مائة وعشرون.
اليمن: ثلاثمائة ألف دينار وسبعون ألف دينار سوى المتاع.
الحجاز: ثلاثمائة ألف دينار. انتهى.
وأما الأندلس فالذي ذكره الثقات من مؤرخيها أن عبد الرحمن الناصر خلف في بيوت أمواله خمسة ألاف ألف ألف دينار مكررة ثلاث مرات، يكون جملتها بالقناطير خمسمائة ألف قنطار. ورأيت في بعض تواريخ الرشيد أن المحمول إلى بيت المال في أيامه سبعة ألاف قنطار وخمسمائة قنطار في كل سنة.
فاعتبر ذلك في نسب الدول بعضها من بعض، ولا تنكرن ما ليس بمعهود عندك ولا في عصرك شيء من أمثاله، فتضيق حوصلتك عند ملتقط الممكنات. فكثير من الخواص إذا سمعوا أمثال هذه الأخبار عن الدول السالفة بادر باب بالإنكار، وليس ذلك من الصواب، فإن أحوال الوجود والعمران متفاوتة، ومن أدرك منها رتبة سفلى أو وسطى فلا يحصر المدارك كلها فيها. ونحن إذا اعتبرنا ما ينقل لنا عن دولة بني العباس وبني أمية والعبيديين، وناسبنا الصحيح من ذلك والذي لا شك فيه بالذي نشاهده من هذه الدول، التي هي أقل بالنسبة إليها وجدنا بينها بوناً وهو لما بينها من التفاوت في أصل قوتها وعمران ممالكها، فالآثار كلها جارية على نسبة الأصل في القوة كما قدمناه ة ولا يسعنا إنكار ذلك عنها، إذ كثير من هذه الأحوال في غاية الشهرة والوضوح، بل فيها ما يلحق، بالمستفيض والمتواتر، وفيها المعاين والمشاهد من آثار البناء وغيره. فخذ من الأحوال المنقولة مراتب الدول في قوتها أو ضعفها وضخامتها أو صغرها، واعتبر ذلك بما نقضه عليك من هذه الحكاية المستظرفة. وذلك أنه ورد بالمغرب لعهد السلطان أبي عنان من ملوك بني مرين رجل من مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطة كان رحل منذ عشرين سنة قبلها إلى المشرق وتقلب في بلاد العراق واليمن والهند، ودخل مدينة دهلي حاضرة ملك الهند، وهو السلطان محمد شاه، واتصل بملكها لذلك العهد وهو فيروزجوه، وكان له منه مكان، واستعمله في خطة القضاء بمذهب المالكية في عمله، ثم انقلب إلى المغرب واتصل بالسلطان أبي عنان، وكان يحدث عن شأن رحلته وما رأى من العجائب بممالك الأرض. وأكثر ما كان يحدث عن دولة صاحب الهند، ويأتي من أحواله بما يستغربه السامعون، مثل أن ملك الهند إذا خرج إلى السفر أحصى أهل مدينته من الرجال والنساء والولدان، وفرض لهم رزق ستة أشهر تدفع لهم من عطائه، وأنه عند رجوعه من سفره في يوم مشهود يبرز فيه الناس كافة إلى صحراء البلد ويطوفون به، وينصب أمامه في ذلك الحفل منجنيقات على الظهر ترمى بها شكائر الدراهم والدنانير على الناس، إلى أن يدخل إيوانه، وأمثال هذه الحكايات، فتناجى الناس بتكذيبه. ولقيت أيامئذ وزير السلطان فارس بن وردار البعيد الصيت، ففاوضته في هذا الشأن وأريته إنكار أخبار ذلك الرجل، لما استفاض في الناس من تكذيبه. فقال لي الوزير فارس: إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول بما أنك لم تره، فتكون كابن الوزير الناشىء في السجن. وذلك أن وزيراً اعتقله سلطانه ومكث في السجن سنين ربي فيها ابنه في ذلك المحبس، فلما أدرك وعقل سأل عن اللحم الذي كان يتغذى به، فقال أبوه هذا لحم الغنم، فقال وما الغنم؟ فيصفها له أبوه بشياتها ونعوتها، فيقول يا أبت تراها مثل الفأر فينكر عليه، ويقول أين الغنم من الفأر، وكذا في لحم الإبل والبقرة إذ لم يعاين في محبسه من الحيوانات إلا الفأر فيحسبها كلها أبناء جنس الفأر. وهذا كثيراً ما يعتري الناس في الأخبار كما يعتريهم الوسواس في الزيادة عن قصد الإغراب كما قدمناه أول الكتاب. فليرجع الإنسان إلى أصوله، وليكن مهيمناً على نفسه، ومميزاً بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته. فما دخل في نطاق الإمكان قبله، وما خرج عنه رفضه. وليس مرادنا الإمكان العقلي المطلق، فإن نطاقه أوسع شيء، فلا يفرض حداً بين الواقعات، وإنما مرادنا الإمكان بحسب المادة التي للشيء. فإنا إذا نظرنا أصل الشيء وجنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوته أجرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله، وحكمنا بالامتناع على ما خرج من نطاقه، " وقل رب زدني علماً، وأنت أرحم الراحمين " . والله سبحانه وتعالى أعلم.
الفصل التاسع عشر
في استظهار صاحب الدولة على قومه
وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعيناعلم أن صاحب الدولة إنما يتم أمره كما قلناه بقومه، فهم عصابته وظهراؤه على شأنه، وبهم يقارع الخوارج على دولته، ومنهم من يقلد أعمال مملكته ووزارة دولته، وجباية أمواله لأنهم أعوانه على الغلب، وشركاؤه في الأمر، ومساهمو في سائر مهماته. هذا ما دام الطور الأول للدولة كما قلناه. فإذا جاء الطور الثاني وظهر الإستبداد عنهم، والإنفراد بالمجد، ودافعهم عنه بالراح، صاروا في حقيقة الأمر من بعض أعدائه، واحتاج في مدافعتهم عن الأمر وصدهم عن المشاركة إلى أولياء آخرين من غير جلدتهم يستظهر بهم عليهم، ويتولاهم دونه، فيكونون أقرب إليه من سائرهم، وأخص به قرباً واصطناعاً، وأولى إيثاراً وجاهاً، لما أنهم يستميتون دونه في مدافعة قومه عن الأمر الذي كان لهم، والرتبة التي ألفوها في مشاركتهم. فيستخلصهم صاحب الدولة حينئذ، ويخصهم بمزيد التكرمة والإيثار، ويقسم لهم مثل ما للكثير من قومه ويقلدهم جليل الأعمال والولايات من الوزارة والقيادة والجباية وما يختص به لنفسه، وتكون خالصة له دون قومه من ألقاب المملكة، لأنهم حينئذ أولياؤه الأقربون ونصحاؤه المخلصون. وذلك حينئذ مؤذن باهتضام الدولة وعلامة على المرض المزمن فيها، لفساد العصبية التي كان بناء الغلب عليها، ومرض قلوب أهل الدولة حينئذ من الامتهان وعداوة السلطان فيضطغنون عليه، ويتربصون به الدوائر، ويعود وبال ذلك على الدولة، ولا يطمع في برئها من هذا الداء، لأن ما مضى يتأكد في الأعقاب إلى أن يذهب رسمها. واعتبر ذلك في دولة بني أمية كيف كانوا إنما يستظهرون في حروبهم وولاية أعمالهم برجال العرب مثل عمر بن سعد بن أبي وقاص، وعبيد الله بن زياد بن أبي سفيان، والحجاج بن يوسف، والمهلب بن أبي صفرة، وخالد بن عبد الله القسري، وابن هبيرة، وموسى بن نصير، وبلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، ونصر بن سيار، وأمثالهم من رجالات العرب. وكذا صدر من دولة بني العباس كان الاستظهار فيها أيضاً برجالات العرب، فلما صارت الدولة للانفراد بالمجد وكبح العرب عن التطاول للولايات، وصارت الوزارة للعجم والصنائع من البرامكة وبني سهل بن نوبخت وبني طاهر، ثم بني بويه وموالي الترك مثل بغا ووصيف وأتامش وباكناك وإبن طولون وأبنائهم، وغير هؤلاء من موالي العجم، فتكون الدولة لغير من مهدها والعز لغير من اجتلبه. سنة الله في عباده، والله تعالى أعلم.
الفصل العشرون
في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول
اعلم أن المصطنعين في الدول يتفاوتون في الالتحام بصاحب الدولة بتفاوت قديمهم وحديثهم في الالتحام بصاحبها. والسبب في ذلك أن المقصود في العصبية من المدافعة والمغالبة إنما يتم بالنسب، لأجل التناصر في ذوي الأرحام والقربى، والتخاذل في الجانب والبعداء كما قدمناه. والولاية والمخالطة بالرق أو بالحلف تتنزل منزلة ذلك، لأن أمر النسب وإن كان طبيعياً فإنما هو وهمي، والمعنى الذي كان به الالتحام إنما هو العشرة والمدافعة وطول الممارسة والصحبة بالمربى والرضاع وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناضر، وهذا مشاهد بين الناس. واعتبر مثله في الاصطناع ة فإنه يحدث بين المصطنع ومن اصطنعه نسبة خاصة من الوصلة تتنزل هذه المنزلة وتؤكد اللحمة، وإن لم يكن نسب فثمرات النسب موجودة. فإذا كانت هذه الولاية بين القبيل وبين أوليائهم قبل حصول الملك لهم، كانت عروقها أوشج، وعقائدها أصح، ونسبها أصرح لوجهين: أحدهما أنهم قبل الملك أسوة في حالهم، فلا يتميز النسب عن الولاية إلا عند الأقل منهم فيتنزلون منهم منزلة ذوي قرابتهم وأهل أرحامهم. وإذا اصطنعوهم بعد الملك كانت مرتبة الملك مميزة للسيد عن المولى، ولأهل القرابة عن أهل الولاية والاصطناع، لما تقتضيه أحوال الرياسة والملك من تميز الرتب وتفاوتها، فتتميز حالتهم ويتنزلون منزلة الأجانب، ويكون الالتحام بينهم أضعف والتناصر لذلك أبعد، وذلك أنقص من الاصطناع قبل الملك.الوجه الثاني: أن الاصطناع قبل الملك يبعد عهده عن أهل الدولة بطول الزمان ويخفي شأن تلك اللحمة، ويظن بها في الأكثر النسب فيقوى حال العصبية. وأما بعد الملك فيقرب العهد ويستوي في معرفته الأكثر، فتتبين اللحمة وتتميز عن النسب، فتضعف العصبية بالنسبة إلى الولاية التي كانت قبل الدولة. واعتبر ذلك في الدول والرياسات تجده. فكل من كان اصطناغه قبل حصول الرياسة والملك لمصطنعه تجده أشد التحاماً به، وأقرب قرابة إليه، ويتنزل منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي رحمه. ومن كان اصطناعه بعد حصول الملك والرياسة لمصطنعه لا يكون له من القرابة واللحمة ما للأولين. وهذا مشاهد بالعيان، حتى أن الدولة في آخر عمرها ترجع إلى استعمال الأجانب واصطناعهم، ولا يبنى لهم مجد كما بناه المصطنعون قبل الدولة، لقرب العهد حينئذ بأوليتهم ومشارفة الدولة على الانقراض، فيكونون منحطين في مهاوي الضعة.
وإنما يحمل صاحب الدولة على اصطناعهم والعدول إليهم عن أوليائها الأقدمين وصنائعها الأولين، ما يعتريهم في أنفسهم من العزة على صاحب الدولة، وقلة الخضوع له، ونظره بما ينظره به قبيله وأهل نسبه، لتأكد اللحمة منذ العصور المتطاولة بالمربى والاتصال بآبائه وسلف قومه، والانتظام مع كبراء أهل بيته، فيحصل لهم بذلك دالة عليه واعتزاز، فينافرهم بسببها صاحب الدولة، ويعدل عنهم إلى استعمال سواهم، ويكون عهد استخلاصهم واصطناعهم قريباً، فلا يبلغون رتب المجد، ويبقون على حالهم من الخارجية، وهكذا شأن الدول في أواخرها. وأكثر ما يطلق اسم الصنائع والأولياء على الأولين. وأما هؤلاء المحدثون فخدم وأعوان. والله ولي المؤمنين، وهو على كل شيء وكيل.
الفصل الحادي والعشرون
فيما يعرض في الدول من حجر السلطان
والاستبداد عليه إذا استقر الملك في نصاب معين ومنبت واحد من القبيل القائمين بالدولة، وانفردوا به ودفعوا سائر القبيل عنه، وتداوله بنوهم واحداً بعد واحد بحسب الترشيح، فربما حدث التغلب على المنصب من وزرائهم وحاشيتهم. وسببه في الأكثر ولاية صبي صغير أو مضعف من أهل المنبت، يترشح للولاية بعهد أبيه أو بترشيح ذويه وخوله، ويؤنس منه العجز عن القيام بالملك، فيقوم به كافله من وزراء أبيه وحاشيته ومواليه أو قبيله، ويوري عنه بحفظ أمره عليه حتى يؤنس منه الاستبداد، ويجعل ذلك ذريعة للملك. فيحجب الصبي عن الناس ويعوده اللذات التي يدعوه إليها ترف أحواله، ويسيمه في مراعيها متى أمكنه، وينسيه النظر في الأمور السلطانية، حتى يستبد عليه. وهو بما عوده يعتقد أن حظ السطان من الملك إنما هو جلوس السرير وإعطاء الصفقة وخطاب التهويل، والقعود مع النساء خلف الحجاب، وأن الحل والربط والأمر والنهي، ومباشرة الأحوال الملوكية، وتفقدها من النظر في الجيش والمال والثغور إنما هو للوزير، ويسلم له في ذلك، إلى أن تستحكم له صبغة الرياسة والاستبداد، ويتحول الملك إليه ويؤثر به عشيرته وأبناءه من بعده. كما وقع لبني بويه والترك وكافور الإخشيدي وغيرهم بالمشرق، وللمنصور بن أبي عامر بالأندلس. وقد يتفطن ذلك المحجور المغلب لشأنه فيحاول على الخروج من ربقة الحجر والاستبداد، ويرجع الملك إلى نصابه، ويضرب على أيدي المتغلبين عليه، إما بقتل أو برفع عن الرتبة فقط، إلا أن ذلك في النادر الأقل، لأن الدولة إذا أخذت في تغلب الوزراء والأولياء استمر لها ذلك، وقل أن تخرج عنه،لأن ذلك إنما يوجد في الأكثر عن أحوال الترف ونشأة أبناء الملك منغمسين في نعيمه، قد نسوا عهد الرجولة وألفوا أخلاق الدايات والاظآر، وربوا عليها، فلا ينزعون إلى رياسة ولا يعرفون استبداداً من تغلب، إنما همهم في القنوع بالأبهة والتفنن في اللذات وأنواع الترف. وهذا التغلب يكون للموالي والمصطنعين عند استبداد عشير الملك على قومهم وانفرادهم به دونهم. وهو عارض للدولة ضروري كما قدمناه. وهذان مرضان لا برء للدولة منهما إلا في الأقل النادر. " والله يؤتي ملكه من يشاء، وهو على كل شيء قدير " .الفصل الثاني والعشرون
في أن المتغلبين على السلطان لا يشاركونه
في اللقب الخاص بالملكوذلك أن الملك والسلطان حصل لأوليه مذ أول الدولة بعصبية قومه، وعصبيته التي استتبعتهم حتى استحكمت له ولقومه صبغة الملك والغلب، وهي لم تزل باقية، وبها انحفظ رسم الدولة وبقاؤها وهذا المتغلب وإن كان صاحب عصبية من قبيل الملك أو الموالي والصنائع فعصبيته مندرجة في عصبية أهل الملك وتابعة لها، وليس له صبغة في الملك. وهو لا يحاول في استبداده انتزاع الملك ظاهراً، وإنما يحاول انتزاع ثمراته من الأمر والنهي، والحل والعقد والإبرام والنقض، يوهم فيها أهل الدولة أنه متصرف عن سلطانه، منفذ في ذلك من وراء الحجاب لأحكامه. فهو يتجافى عن سمات الملك وشاراته وألقابه جهده ويبعد نفسه عن التهمة بذلك وإن حصل له الاستبداد لأنه مستتر في استبداده ذلك بالحجاب الذي ضربه السلطان وأولوه على أنفسهم عن القبيل منذ أول الدولة، ومغالط عنه بالنيابة. ولو تعرض لشيء من ذلك لنفسه عليه أهل العصبية وقبيل الملك، وحاولوا الاستئثار به دونه، لأنه لم تستحكم له في ذلك صبغة تحملهم على التسليم له والانقياد، فيهلك لأول وهلة. وقد وقع مثل هذا لعبد الرحمن بن الناصر بن المنصور بن أبي عامر، حين سما إلى مشاركة هشام وأهل بيته في لقب الخلافة، ولم يقنع بما قنع به أبوه وأخوه من الاستبداد بالحل والعقد والمراسم المتتابعة. فطلب من هشام خليفته أن يعهد له بالخلافة، فنفس ذلك عليه بنو مروان وسائر قريش، وبايعوا لابن عم الخليفة هشام محمد بن عبد الجبار بن الناصر، وخرجوا عليه. وكان في ذلك خراب دولة العامريين وهلاك المؤيد خليفتهم، واستبدل منه سواه من أعياص الدولة إلى آخرها، واختلت مراسم ملكهم. والله خير الوارثين.
الفصل الثالث والعشرون
في حقيقة الملك وأصنافه
الملك منصب طبيعي للإنسان لأنا قد بينا أن البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضرورياتهم. وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات، ومد كل واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه، لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم على بعض، ويمانعه الآخر عنها بمقتضى الغضب والأنفة ومقتضى القوة البشرية في ذلك، فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة، وهي تؤدي إلى الهرج وسفك الدماء وإذهاب النفوس، المفضي ذلك إلى انقطاع النوع، وهو مما خصة الباري سبحانه بالمحافظة، واستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض، واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو الحاكم عليهم، وهو بمقتضى الطبيعة البشرية الملك القاهر المتحكم. ولا بد في ذلك من العصبية لما قدمناه، من أن المطالبات كلها والمدافعات لا تتم إلا بالعصبية. وهذا الملك كما تراه منصب شريف تتوجه نحوه المطالبات ويحتاج إلى المدافعات، ولا يتم شيء من ذلك إلا بالعصبيات كما مر. والعصبيات متفاوتة، وكل عصبية فلها تحكم وتغلب على من يليها من قومها وعشيرها. وليس الملك لكل عصبية، وإنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية ويجبي الأموال ويبعث البعوث ويحمي الثغور، ولا تكون فوق يده يد قاهرة. وهذا معنى الملك وحقيقته في المشهور. فمن قصرت به عصبيته عن بعضها، مثل حماية الثغورأو جباية الأموال أو بعث البعوث فهو ملك ناقص لم تتم حقيقته، كما وقع لكثير من ملوك البربر في دولة الأغالبة بالقيروان ولملوك العجم صدر الدولة العباسية. ومن قصرت به عصبيته أيضاً عن الاستعلاء على جميع العصبيات، والضرب على سائر الأيدي، وكان فوقه حكم غيره، فهو أيضاً ملك ناقص لم تتم حقيقته، وهؤلاء مثل أمراء النواحي ورؤساء الجهات الذين تجمعهم دولة واحدة. وكثيراً ما يوجد هذا في الدولة المتسعة النطاق، أعني توجد ملوك على قومهم في النواحي القاصية يدينون بطاعة الدولة التي جمعتهم، مثل صنهاجة مع العبيديين، وزناتة مع الأمويين تارة والعبيديين تارة أخرى، ومثل ملوك العجم في دولة بني العباس، ومثل أمراء البربر وملوكهم مع الفرنجة قبل الإسلام، ومثل ملوك الطوائف من الفرس مع الإسكندر وقومه اليونانيين، وكثير من هؤلاء. فاعتبره تجده. والله القاهر فوق عباده.الفصل الرابع والعشرون
في أن إرهاف الحد مضر بالملك
ومفسد له في الأكثراعلم أن مصلحة الرعية في السلطان ليست في ذاته وجسمه من حسن شكله أو ملاحة وجهه أو عظم جثمانه أو اتساع عمله أو جودة خطه أو ثقوب ذهنه، وإنما مصلحتهم فيه من حيث إضافتة إليهم، فإن الملك والسلطان من الأمور الإضافية، وهي نسبة بين منتسبين. فحقيقة السلطان أنه المالك للرعية القائم في أمورهم عليهم، فالسلطان من له رعية والرعية من لها سلطان، والصفة التي له من حيث إضافته لهم هي التي تسمى الملكة وهي كونه يملكهم فإذا كانت هذه الملكة وتوابعها من الجودة بمكان حصل المقصود من السلطان على أتم الوجوه، فإنها إن كانت جميلة صالحة كان ذلك مصلحة لهم، وإن كانت سيئة متعسفة كان ذلك ضرراً عليهم وإهلاكاً لهم.
ويعود حسن الملكة إلى الرفق. فإن الملك إذا كان قاهراً، باطشاً بالعقوبات، منقباً عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم، شملهم الخوف والذل، ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بها، وفسدت بصائرهم وأخلاقهم، وربما خذلوه في مواطن الحروب والمددافعات، ففسدت الحماية بفساد النيات، وربما أجمعوا على قتله لذلك فتفسد الدولة ويخرب السياج، وإن دام أمره عليهم وقهره فسدت العصبية لما قلناه أولاً، وفسد السياج من أصله بالعجز عن الحماية. وإذا كان رفيقاً بهم متجاوزاً عن سيئاتهم استناموا إليه ولاذوا به وأشربوا محبته واستماتوا دونه في محاربة أعدائه، فاستقام الأمر من كل جانب.
وأما توابع حسن الملكة فهي النعمة عليهم والمدافعة عنهم فالمدافعة بها تتم حقيقة الملك، وأما النعمة عليهم والإحسان لهم فمن جملة الرفق بهم، والنظر لهم في معاشهم، وهي أصل كبير في التحبب إلى الرعية. واعلم أنه قلما تكون ملكة الرفق فيمن يكون يقظاً شديد الذكاء من الناس، وأكثر ما يوجد الرفق في الغفل والمتغفل. وأقل ما يكون في اليقظ أنه يكلف الرعية فوق طاقتهم لنفوذ نظره فيما وراء مداركهم واطلاعه على عواقب الأمور في مباديها بألمعيته فيهلكون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: " سيروا على سير أضعفكم " . ومن هذا الباب اشترط الشارع في الحاكم قلة الإفراط في الذكاء، ومأخذه من قصة زياد بن أبى سفيان لما عزله عمر عن العراق، وقال: " لم عزلتني يا أمير المومنين؟ ألعجز أم لخيانة؟ " فقال عمر: " لم أعزلك لواحدة منهما، ولكني كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس " . فأخذ من هذا أن الحاكم لا يكون مفرط الذكاء والكيس مثل زياد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، لما يتبع ذلك من التعسف وسوء الملكة، وحمل الوجود على ما ليس في طبعه، كما يأتي في آخر هذا الكتاب. والله خير المالكين.
وتقرر من هذا أن الكيس والذكاء عيب في صاحب السياسة، لأنه إفراط في الفكر، كما أن البلادة إفراط في الجمود. والطرفان مذمومان من كل صفة إنسانية، والمحمود هو التوسط: كما في الكرم مع التبذير والبخل، وكما في الشجاعة مع الهوج والجبن، وغير ذلك من الصفات الإنسانية. ولهذا يوصف الشديد الكيس بصفات الشيطان، فيقال شيطان ومتشيطن وأمثال ذلك. والله يخلق ما يشاء، وهو العليم القدير.
الفصل الخامس والعشرون
في معني الخلافة والإمامة
لما كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر، ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية، كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق، مجحفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم، لحمله إياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من الخلف والسلف منهم، فتعسر طاعته لذلك، وتجيء العصبية المفضية إلى الهرج والقتل. فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأمم. وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها، ولا يتم استيلاؤها: " سنة الله في الذين خلوا من قبل " .فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الأخرة. وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط، فإنها كلها عبث وباطل إذ غايتها الموت والفناء، والله يقول: " أفحسبتم إنما خلقناكم عبثاً، فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم. " صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض " . فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة، حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني، فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل محوطاً بنظر الشارع.
فما كان منه بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة العصبية في مرعاها فجور وعدوان ومذموم عنده كما هو مقتضى الحكمة السياسية. وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضاً، لأنه نظر بغير نور الله: " ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور " . لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم، وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم، من ملك أو غيره، قال صلى الله عليه وسلم: " إنما هي أعمالكم ترد عليكم " ، وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط. " يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا " ، ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم. وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء.
فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة، وأن الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسي هو حمل الكافة على مقتضي النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في جراسة الدين وسياسة الدنيا به. فافهم ذلك واعتبره فيما نورده عليك، من بعد. والله الحكيم العليم.
الفصل السادس والعشرون
في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه
وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب، وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، تسمى خلافة وإمامة، والقائم به خليفة وإماماً. فأما تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به، ولهذا يقال: الإمامة الكبرى. وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في أمته، فيقال: خليفة بإطلاق، وخليفة رسول الله. واختلف في تسميته خليفة الله. فأجازه بعضهم اقتباساً من الخلافة العامة التي للآدميين في قوله تعالى: " إني جاعل في الأرض خليفة " وقوله: " جعلكم خلائف الأرض " . ومنع الجمهور منه، لأن معنى الآية ليس عليه، وقد نهى أبو بكر عنه لما دعي به، وقال: " لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولأن الاستخلاف إنما هو في حق الغائب، وأما الحاضر فلا.ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم. وكذا في كل عصرمن بعد ذلك. ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار. واستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام. وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل، وأن الإجماع الذي وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه، قالوا وإنما وجب بالعقل لضرورة الإجتماع للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم منفردين، ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض. فما لم يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم، مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية. وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه الحكماء في وجوب النبوات في البشر. وقد نبهنا على فساده، وأن إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون بشرع من الله تسلم له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مسلم، لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل الشوكة ولو لم يكن شرع، كما في أمم المجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة، أو نقول يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بحكم العقل، فادعاؤهم أن ارتفاع التنازع إنما يكون بوجود الشرع هناك، ونصب الإمام هنا غير صحيح، بل كما يكون بنصب الإمام يكون بوجود الرؤساء أهل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم، فلا ينهض دليلهم العقلي المبني على هذه المقدمة. فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع وهو الاجماع الذي قدمناه.
وقد شد بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا النصب رأساً لا بالعقل ولا بالشرع، منهم الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم، والواجب عند هؤلاء إنما هو إمضاء أحكام الشرع، فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج إلى إمام ولا يجب نصبه. وهؤلاء محجوجون بالإجماع. والذي حملهم على هذا المذهب إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا، لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك، والنعي على أهله، ومرغبة في رفضه.
واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته ولا حظر القيام به، وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القهر والظلم والتمتع باللذات، ولا شك أن في هذه مفاسد محظورة وهي من توابعه، كما أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه، وأوجب بإزائها الثواب وهي كلها من توابع الملك. فإذا إنما وقع الذم للملك على صفة وحال دون حال أخرى، ولم يذمه لذاته، ولا طلب تركه، كما ذم الشهوة والغضب من المكلفين، وليس مراده تركهما بالكلية لدعاية الضرورة إليها، وإنما المراد تصريفهما على مقتضى الحق.
وقد كان لداود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهما الملك الذي لم يكن لغيرهما، وهما من أنبياء الله تعالى وأكرم الخلق عنده. ثم نقول لهم أن هذا الفرارعن الملك بعدم وجوب هذا النصب لا يغنيكم شيئاً، لأنكم موافقون على وجوب إقامة أحكام الشريعة، وذلك لا يحصل إلا بالعصبية والشوكة، والعصبية مقتضية بطبعها للملك، فيحصل الملك وإن لم ينصب إمام، وهو عين ما فررتم.
وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد والحل، فيتعين عليهم نصبه، ويجب على الخلق جميعاً طاعته، لقوله تعالى: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " .
وأما شروط هذا المنصب فهي أربعة: العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء، مما يؤثر في الرأي والعمل. واختلف في شرط خامس وهو النسب القرشي.
فأما اشتراط العلم فظاهر، لأنه إنما يكون منفذاً لأحكام الله تعالى إذا كان عالماً بها، وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لها. ولا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهداً، لأن التقليد نقص، والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال.
وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها، فكان أولى باشتراطها فيه. ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالها. وفي انتفائها بالبدع الاعتقادية خلاف.
وأما الكفاية فهو أن يكون جريئاً على إقامة الحدود واقتحام الحروب بصيراً بها، كفيلاً بحمل الناس عليها، عارفاً بالعصبية وأحوال الدهاء، قوياً على معاناة السياسة، ليصح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين، وجهاد العدو، وإقامة الأحكام، وتدبير المصالح.
وأما سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة كالجنون والعمى والصمم والخرس، وما يؤثر فقده من الأعضاء في العمل كفقد اليدين والرجلين والأنثيين فتشترط السلامة منها كلها، لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامه بما جعل إليه. وإن كان إنما يشين في المنظر فقط، كفقد إحدى هذه الأعضاء، فشرط السلامة منه شرط كمال. ويلحق بفقدان الأعضاء المنع من التصرف. وهو ضربان: ضرب يلحق بهذه في اشتراط السلامة منه شرط وجوب وهو القهر والعجز عن التصرف جملة بالأسر وشبهه، وضرب لا يلحق بهذه وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانه عليه من غيرعصيان ولا مشاقة، فينتقل النظر في حال هذا المستولي، فإن جرى على حكم الدين والعدل وحميد السياسة جاز قراره، وإلا استنصر المسلمون بمن يقبض يده عن ذلك ويدفع علته، حتى ينفذ فعل الخليفة. وأما النسب القرشي فلإجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك، واحتجت قريش على الأنصار لما هموا يومئذ ببيعة سعد بن عبادة وقالوا: " منا أمير ومنكم أمير " بقوله صلى الله عليه وسلم: " الأئمة من قريش " وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم ونتجاوز عن مسيئكم، ولو كانت الأمارة فيكم لم تكن الوصية بكم، فحجوا الأنصار، ورجعوا عن قولهم: " منا أمير ومنكم أمير " ، وعدلوا عما كانوا هموا به من بيعة سعد لذلك. وثبت أيضاً في الصحيح: " لا يزال هذا الأمر في هذا الحي من قريش وأمثال هذه الأدلة كثيرة.
إلا أنة لما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترف والنعيم، وبما أنفقتهم الدولة في سائر أقطار الأرض عجزوا بذلك عن حمل الخلافة، وتغلبت عليهم الأعاجم وصار الحل والعقد لهم، فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حتى ذهبوا إلى نفي اشتراط القرشية وعولوا على ظواهر في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة " ، وهذا لا تقوم به حجة في ذلك، فإنة خرج مخرج التمثيل والفرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة، ومثل قول عمر لو كان سالم مولى حذيفة حياً لوليته " أو " لما دخلتني فيه الظنة " ، وهو أيضاً لا يفيد ذلك لما علمت أن مذهب الصحابي ليس بحجة، وأيضاً فمولى القوم منهم، وعصبية الولاء حاصلة لسالم. في قريش، وهي الفائدة في اشتراط النسب. ولما استعظم عمر أمر الخلافة ورأى شروطها كأنها مفقودة في ظنه، عدل إلى سالم لتوفر شروط الخلافة عنده فيه، حتى من النسب المفيد للعصبية كما نذكر، ولم يبق إلا صراحة النسب فرآه غير محتاج إليه، إذ الفائدة في النسب إنما هي العصبية وهي حاصلة من الولاء. فكان ذلك حرصاً من عمر رضي الله عنه على النظر للمسلمين وتقليد أمرهم لمن لا تلحقه فيه لائمة ولا عليه فيه عهدة.
ومن القائلين بنفي اشتراط القرشية القاضي أبو بكر الباقلاني، لما أدرك عليه عصبية قريش من التلاشي والاضمحلال واستبداد ملوك العجم على الخلفاء، فأسقط شرط القرشية، وإن كان موافقاً لرأي الخوارج، لما رأى عليه حال الخلفاء لعهده. وبقي الجمهور على القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشي، ولو كان عاجزاً عن القيام بأمور االمسلمين. ورد عليهم سقوط شرط الكفاية التي يقوى بها على أمره، لأنه إذا ذهبت الشوكة بذهاب العصبية فقد ذهبت الكفاية، وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية تطرق ذلك أيضاً إلى العلم والدين، وسقط اعتبار شروط هذا المنصب وهو خلاف الإجماع.
ولنتكلم الآن في حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصواب في هذه المذاهب فنقول: أن الأحكام الشرعية كلها لا بد لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها، وتشرع لأجلها. ونحن إذ ا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه، لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في المشهور، وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها حاصلاً، لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما علمت، فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتها. وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة، ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها، وينتظم حبل الألفة فيها. وذلك أن قريشاً كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب منهم، وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف. فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويسكينون لغلبهم، فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم، وعدم انقيادهم، ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف، ولا يحملهم على الكرة، فتفترق الجماعة وتختلف الكلمة. والشارع محذر من ذلك حريص على اتفاقهم، ورفع التنازع والشتات بينهم، لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية. بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش، لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب إلى ما يراد منهم، فلا يخشى من أحد خلاف عليهم ولا فرقة، لأنهم كفيلون حينئذ بدفعها ومنع الناس منها. فاشترط نسبهم القرشي في هذا المنصب، وهم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة، وإذا انتظمت كلمتهم انتظمت بانتظامها كلمة مضر أجمع، فأذعن لهم سائر العرب، وانقادت الأمم سواهم إلى أحكام الملة، ووطئت جنودهم قاصية البلاد كما وقع في أيام الفتوحات، واستمر بعدها في الدولتين إلى أن اضمحل أمر الخلافة، وتلاشت عصبية العرب. ويعلم ما كان لقريش من الكثرة والتغلب على بطون مضر، من مارس أخبار العرب وسيرهم وتفطن لذلك في أحوالهم. وقد ذكر ذلك ابن إسحق في كتاب السير وغيره. فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة، علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على، المقصود من القر شية وهي وجود العصبية، فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها، ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية. ولا يعلم ذلك في الأقطار والآفاق كما كان في القرشية، إذ الدعوة الإسلامية التي كانت لهم كانت عامة، وعصبية العرب كانت وافية بها فغلبوا سائر الأمم وإنما يخص لهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة. وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا، لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائباً عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارهم، وهو مخاطب بذلك، ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه. ألا ترى ما ذكره الإمام ابن الخطيب في شأن النساء وأنهن في كثير من الأحكام الشرعية جعلن تبعاً للرجال ولم يدخلن في الخطاب بالوضع وإنما دخلن عنده بالقياس، وذلك لما لم يكن لهن من الأمر شيء وكان الرجال قوامين عليهن، اللهم إلا في العبادات التي كل أحد فيها قائم على نفسه، فخطابهن فيها بالوضع لا بالقياس. ثم أن الوجود شاهد بذلك، فإنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم. وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفاً للأمر الوجودي. والله تعالى أعلم.
الفصل السابع والعشرون
في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة
اعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والأتباع، ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم. ومذهبهم جميعاً متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، ويتعين القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر، وأن علياً رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم، لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة، بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه، أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة. وتنقسم هذه النصوص عندهم إلى جلي وخفي: فالجلي مثل قوله: " من كنت مولاه فعلي مولاه " . قالوا: ولم تطرد هذه الولاية إلا في علي، ولهذا قال له عمر: " أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة " . ومنها قوله: أقضاكم علي، ولا معنى للإمامة إلا القضاء بأحكام الله وهو المراد بأولي الأمر الواجبة طاعتهم بقوله: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " ، والمراد الحكم والقضاء. ولهذا كان حكماً في قضية الإمامة يوم السقيفة دون غيره. ومنها قوله: " من يبايعني على روحه وهو وصي وولي هذا الأمر من بعدي " ، فلم يبايعه إلا علي.
ومن الخفي عندهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم علياً لقراءة سورة براءة في الموسم حين أنزلت، فإنه بعث بها أولاً أبا بكر ثم أوحي إليه ليبلغه رجل منك أو من قومك، فبعث علياً ليكون القارىء المبلغ. قالوا: وهذا يدل على تقديم علي. وأيضاً فلم يعرف أنه قدم أحداً على علي. وأما أبو بكر وعمر فقدم عليهما في غزاتين، أسامة بن زيد مرة وعمرو بن العاص اخرى. وهذه كلها أدلة شاهدة بتعين علي للخلافة دون غيره. فمنها ما هو غير معروف ومنها ما هو بعيد عن تأويلهم.
ثم منهم من يرى أن هذه النصوص تدل على تعيين علي وتشخيصه، وكذلك تنتقل منه إلى من بعده وهؤلاء هم الإمامية، ويتبرؤون من الشيخين حيث لم يقدموا علياً ويبايعوه بمقتضى هذه النصوص، ويغمصون في إمامتهما. ولا يلتفت إلى نقل القدح فيهما من غلاتهم فهو مردود عندنا وعندهم.
ومنهم من يقول: أن هذه الأدلة إنما اقتضت تعيين علي بالوصف لا بالشخص، والناس مقصرون حيث لم يضعوا الوصف موضعه، وهؤلاء هم الزيدية، ولا يتبرؤون من الشيخين ولا يغمصون في إمامتهما مع قولهم بأن علياً أفضل منهما، لكنهم يجوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل.
ثم اختلفت نقول هؤلاء الشيعة في مساق الخلافة بعد علي: فمنهم من ساقها في ولد فاطمة بالنص عليهم واحداً بعد واحد على ما يذكر بعد، وهؤلاء يسمون الإمامية نسبة إلى مقالتهم باشتراط معرفة الإمام وتعيينه في الإيمان، وهي أصل عندهم، ومنهم من ساقها في ولد فاطمة لكن بالاختيار من الشيوخ، ويشترط أن يكون الإمام منهم عالماً زاهداً جواداً شجاعاً داعياً إلى إمامته، وهؤلاء هم الزيدية نسبة إلى صاحب المذهب، وهو زيد بن علي بن الحسين السبط، وقد كان يناظر أخاه محمداً الباقر على اشتراط الخروح في الإمام، فيلزمه الباقر أن لا يكون أبوهما زين العابدين إماماً لأنه لم يخرج ولا تعرض للخروج. وكان مع ذلك ينعى عليه مذاهب المعتزلة وأخذه إياها عن واصل بن عطاء. ولما ناظر الإمامية زيداً في إمامة الشيخين ورأوه يقول بإمامتهما ولا يتبرأ منهما رفضوه ولم يجعلوه من الأئمة، وبذلك سموا رافضة. ومنهم من ساقها بعد علي وابنيه السبطين على اختلافهم في ذلك إلى أخيهما محمد بن الحنفية، ثم إلى ولده، وهم الكيسانية نسبة إلى كيسان مولاه. وبين هذه الطوائف اختلافات كثيرة تركناها اختصاراً.
ومنهم طوائف يسمون الغلاة تجاوزوا حد العقل والإيمان في القول بألوهية هؤلاء الأئمة. إما على أنهم بشر اتصفوا بصفات ألوهية، أو أن الإله حل في ذاتهم البشرية، وهو قول بالحلول يوافق مذهب النصارى في عيسى صلوات الله عليه. ولقد حرق علي رضي الله عنه بالنار من ذهب فيه إلى ذلك منهم، وسخط محمد بن الحنفية المختار بن أبي عبيد لما بلغه مثل ذلك عنه، فصرح بلعنته والبراءة منه، وكذلك فعل جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه بمن بلغه مثل هذا عنه. ومنهم من يقول: أن كمال الإمام لا يكون لغيره، فإذا مات انتقلت روحه إلى إمام آخر ليكون فيه ذلك الكمال، وهو قول بالتناسخ.
ومن هؤلاء الغلاة من يقف عند واحد من الأئمة لا يتجاوزه إلى غيره بحسب من يعين لذلك عندهم، وهؤلاء هم الواقفية. فبعضهم يقول هو حي لم يمت إلا أنه غائب عن أعين الناس، ويستشهدون لذلك بقصة الخضر، قيل مثل ذلك في علي رضي الله عنه وإنه في السحاب، والرعد صوته، والبرق في سوطه. وقالوا مثله في محمد بن الحنفية وإنه في جبل رضوى من أرض الحجاز، وقال شاعرهم:
ألا إن الأئمة من قريش ... ولاة الحق أربعة سواء:
علي والثلاثة من بنيه ... هم الأسباط ليس بهم خفاء
فسبط سبط إيمان وبر ... وسبط غيبته كربلاء
وسبط لايذوق الموت ... حتى يقود الجيش يقدمه اللواء
تغيب لايرى فيهم زماناً ... برضوى عنده عسل وماء
وقال مثله غلاة الإمامية، وخصوصاً الاثني عشرية منهم يزعمون أن الثاني عشر من أئمتهم، وهو محمد بن الحسن العسكري ويلقبونه المهدي دخل في سرداب بدارهم بالحلة وتغيب حين اعتقل مع أمه وغاب هنالك، وهو يخرج آخر الزمان فيملأ الأرض عدلاً يشيرون بذلك إلى الحديث الواقع في كتاب الترمذي في المهدي، وهم إلى الآن ينتظرونه ويسمونة المنتظر لذلك، ويقفون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب هذا السرداب، وقد قوموا مركباً فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج، حتى تشتبك النجوم، ثم ينفضون ويرجئون الأمر إلى الليلة الأتية، وهم على ذلك لهذا العهد.
وبعض هؤلاء الواقفية يقول: أن الإمام الذي مات يرجع إلى حياته الدنيا. ويستشهدون لذلك بما وقع في القرآن الكريم من قصة أهل الكهف، والذي مر على قرية، وقتيل بني إسرائيل حين ضرب بعظام البقرة التي أمروا بذبحها. ومثل ذلك من الخوارق التي وقعت على طريق المعجزة، ولا يصح الاستشهاد بها في غير مواضعها. وكان من هؤلاء السيد الحميري، ومن شعره في ذلك:
إذا ما المرء شاب له قذال ... وعلله المواشط بالخضاب
فقد ذهبت بشاشته وأودى ... فقم ياصاح نبك على الشباب
إلى يوم تؤوب الناس فيه ... إلى دنيا همو قبل الحساب
فليس بعائد ما فات منه ... إلى أحد إلى يوم الإياب
أدين بأن ذلك دين حق ... وما أنا في النشور بذي ارتياب
كذاك الله أخبر عن أناس ... حيوا من بعد درس في التراب
وقد كفانا مؤونة هؤلاء الغلاة أئمة الشيعة، فإنهم لا يقولون بها ويبطلون احتجاجاتهم عليها.
وأما الكيسانية فساقوا الإمامة من بعد محمد بن الحنفية إلى ابنه أبي هاشم، وهؤلاء هم الهاشمية. ثم افترقوا فمنهم من ساقها بعده إلى أخيه علي ثم إلى ابنه الحسن بن علي. وآخرون يزعمون أن أبا هاشم لما مات بأرض السراة منصرفاً من الشام أوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم المعروف بالإمام، وأوصى إبراهيم إلى أخيه عبد الله بن الحارثية الملقب بالسفاح، وأوصى هو إلى أخيه عبد الله أبي جعفر الملقب بالمنصور، وانتقلت في ولده بالنص والعهد واحداً بعد واحد إلى آخرهم. وهذا مذهب الهاشمية القائمين بدولة بني العباس. وكان منهم أبو مسلم وسليمان بن كثير، وأبو سلمة الخلال وغيرهم من شيعة العباسية. وربما يعضدون ذلك بأن حقهم في هذا الأمر يصل إليهم من العباس لأنه كان حياً وقت الوفاة، وهو أولى بالوراثة بعصبية العمومة.
وأما الزيدية فساقوا الإمامة على مذهبهم فيها وأنها باختيار أهل الحل والعقد لا بالنص. فقالوا بإمامة علي، ثم ابنه الحسن، ثم أخيه الحسين، ثم ابنه علي زين العابدين، ثم ابنه زيد بن علي وهو صاحب هذا المذهب. وخرج بالكوفة داعياً إلى الإمامة فقتل وصلب بالكناسة. وقال الزيدية بإمامة ابنه يحيى من بعده، فمضى إلى خراسان وقتل بالجوزجان، بعد أن أوصى إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن السبط، ويقال له النفس الزكية، فخرج بالحجاز وتلقب بالمهدي وجاءته عساكر المنصور فقتل، وعهد إلى أخيه إبراهيم، فقام بالبصرة ومعه عيسى بن زيد بن علي، فوجه إليهم المنصور عساكره فهزم، وقتل إبراهيم وعيسى، وكان جعفر الصادق أخبرهم بذلك كله، وهي معدودة في كراماته.
وذهب آخرون منهم إلى أن الإمام بعد محمد بن عبد الله النفس الزكية هو محمد بن القاسم بن علي بن عمر، وعمر هوأخو زيد بن علي، فخرج محمد بن القاسم بالطالقان، فقبض عليه وسيق إلى المعتصم فحبسه ومات في حبسه. وقال آخرون من الزيدية: أن الإمام بعد يحيى بن زيد هو أخوه عيسى الذي حضر مع إبراهيم بن عبد الله في قتاله مع المنصور، ونقلوا الإمامة في عقبه، وإليه انتسب دعي الزنج كما نذكره في أخبارهم.
وقال آخرون من الزيدية: أن الإمام بعد محمد بن عبد الله أخوه إدريس الذي فر إلى المغرب ومات هنالك، وقام بأمره ابنه إدريس واختط مدينة فاس، وكان من بعده عقبه ملوكاً بالمغرب إلى أن انقرضوا كما نذكره في أخبارهم.
وبقي أمر الزيدية بعد ذلك غير منتظم. وكان منهم الداعي الذي ملك طبرستان، وهو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين السبط، وأخوه محمد بن زيد. ثم قام بهذه الدعوة في الديلم الناصر الأطروش منهم، وأسلموا على يده، وهو الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر، وعمر أخو زيد بن علي، فكانت لبنيه بطبرستان دولة، وتوصل الديلم من نسبهم إلى الملك والاستبداد على الخلفاء ببغداد كما نذكر في أخبارهم.
وأما الإمامية فساقوا الإمامة من علي الرضا إلى ابنه الحسن بالوصية، ثم إلى أخيه الحسين، ثم إلى ابنه علي زين العابدين، ثم إلى ابنه محمد الباقر، ثم إلى ابنه جعفر الصادق. ومن هنا افترقوا فرقتين: فرقة ساقوها إلى ولده إسماعيل ويعرفونه بينهم بالإمام وهم الإسماعيلية، وفرقة ساقوها إلى ابنه موسى الكاظم وهم الاثنا عشرية لوقوفهم عند الثاني عشر من الأئمة وقولهم بغيبته إلى آخر الزمان كما مر.
فأما الإسماعيلية فقالوا بإمامة إسماعيل الإمام بالنص من أبيه جعفر. وفائدة النص عليه عندهم، وإن كان قد مات قبل أبيه إنما هو بقاء الإمامة في عقبه كقصة هارون مع موسى صلوات الله عليهما. قالوا: ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلى ابنه محمد المكتوم، وهو أول الأئمة المستورين، لأن الإمام عندهم قد لا يكون له شوكة فيستتر وتكون دعاته ظاهرين إقامة للحجة على الخلق، وإذا كانت له شوكة ظهر وأظهر دعوته. قالوا وبعد محمد المكتوم ابنه جعفر الصادق وبعده ابنه محمد الحبيب وهو آخر المستورين، وبعده ابنه عبد الله المهدي الذي أظهر دعوته أبو عبد الله الشيعي في كتامة، وتتابع الناس على دعوته، ثم أخرجه من معتقله بسجلماسة، وملك القيروان والمغرب وملك بنوه من بعده مصر كما هو معروف في أخبارهم.
ويسمى هؤلاء الإسماعيلية، نسبة إلى القول بإمامة إسماعيل، ويسمون أيضاً بالباطنية نسبة إلى قولهم بالإمام الباطن أي المستور، ويسمون أيضاً الملحدة لما في ضمن مقالتهم من الإلحاد. ولهم مقالات قديمة ومقالات جديدة دعا إليها الحسن بن محمد الصباح في آخر المائة الخامسة، وملك حصوناً بالشام والعراق، ولم تزل دعوته فيها إلى أن توزعها الهلاك بين ملوك الترك بمصر، وملوك التتر بالعراق فانقرضت. ومقالة هذا الصباح في دعوته مذكورة في كتاب الملل والنحل للشهرستاني.
وأما الاثنا عشرية خصوا باسم الإمامية عند المتأخرين منهم، فقالوا بإمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق لوفاة أخيه الأكبر إسماعيل الإمام في حياة أبيهما جعفر، فنص على إمامة موسى هذا، ثم ابنه علي الرضا الذي عهد إليه المأمون ومات قبله فلم يتم له أمر، ثم ابنه محمد التقي، ثم ابنه علي الهادي، ثم ابنه محمد بن الحسن العسكري، ثم ابنه محمد المهدي المنتظر الذي قدمناه قبل.
وفي كل واحدة من هذه المقالات للشيعة اختلاف كثيرة إلا أن هذه أشهر مذاهبهم، ومن أراد استيعابها ومطالعتها فعليه بكتاب " الملل والنحل " لابن حزم والشهرستاني وغيرهما، ففيها بيان ذلك. والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو العلي الكبير.
الفصل الثامن والعشرون
في انقلاب الخلافة إلي الملك
اعلم أن الملك غاية طبيعية للعصبية، ليس وقوعه عنها باختيار، إنما هو بضرورة الوجود وترتيبه كما قلناه من قبل، وأن الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه الجمهور فلا بد فيه من العصبية، إذ المطالبة لا تتم إلا بها كما قدمناه، فالعصبية ضرورية للملة وبوجودها يتم أمر الله منها. وفي الصحيح: " ما بعث الله نبياً إلا في منعة من قومه " . ثم وجدنا الشارع قد ذم العصبية وندب إلى اطراحها وتركها فقال: " إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، أنتم بنو آدم وآدم من تراب " ، وقال تعالى: " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " . ووجدناه أيضاً قد ذم الملك وأهله ونعى على أهله أحوالهم من الاستمتاع بالخلاق، والإسراف في غير القصد والتنكب عن صراط الله. وإنما حض على الألفة في الدين وحذر من الخلاف والفرقة.واعلم أن الدنيا كلها وأحوالها عند الشارع مطية للآخرة، ومن فقد المطية فقد الوصول. وليس مراده فيما ينهى عنه أو يذمه من أفعال البشر أو يندب إلى تركه إهماله بالكلية أو اقتلاعه من أصله، وتعطيل القوى التي ينشأ عليها بالكلية، إنما قصده تصريفها في أغراض الحق جهد الاستطاعة، حتى تصير المقاصد كلها حقاً وتتحد الوجهة، كما قال صلى الله عليه وسلم: " من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه " . فلم يذم الغضب وهو يقصد نزعه من الإنسان، فإنه لو زالت منه قوة الغضب لفقد منه الانتصار للحق وبطل الجهاد إعلاء كلمة الله، وإنما يذم الغضب للشيطان وللأغراض الذميمة، فإذا كان الغضب لذلك كان مذموماً وإذا كان الغضب في الله ولله كان ممدوحاً، وهو من شمائله صلى الله عليه وسلم.
وكذا ذم الشهوات أيضاً ليس المراد إبطالها بالكلية، فإن من بطلت شهوته كان نقصاً في حقه وإنما المراد تصريفها فيما أبيح له باشتماله على المصالح، ليكون الإنسان عبداً متصرفاً طوع الأوامر الإلهية، وكذا العصبية حيث ذمها الشارع، وقال: " لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم " فإنما مراده حيث تكون العصبية على الباطل وأحواله كما كانت في الجاهلية، وأن يكون لأحد فخربها أو حق على أحد، لأن ذلك مجان من أفعال العقلاء وغير نافع في الأخرة التي هي دار القرار. فأما إذا كانت العصبية في الحق وإقامة أمر الله فأمر مطلوب، ولو بطل لبطلت الشرائع إذ لا يتم قوامها إلا بالعصبية كما قلناه من قبل. وكذا الملك لما ذمه الشارع لم يذم منه الغلب بالحق وقهر الكافة على الدين، ومراعاة المصالح، وإنما ذمه لما فيه من التغلب بالباطل وتصريف الأدميين طوع الأغراض والشهوات كما قلناه. فلو كان الملك مخلصاً في غلبه للناس أنه لله ولحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذموماً.
وقد قال سليمان صلوات الله عليه: " رب هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي " ، لما علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة والملك.
ولما لقي معاوية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند قدومه إلى الشام في أبهة الملك وزيه من العديد والعدة استنكر ذلك وقال: " أكسروية يا معاوية؟ " ، فقال. " يا أمير المؤمنين إنا في ثغر تجاه العدو وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة " ، فسكت ولم يخطئة لما احتج عليه بمقصد من مقاصد الحق والدين. فلو كان القصد رفض الملك أصله لم يقنعه هذا الجواب في تلك الكسروية وانتحالها، بل كان يحرض على وجه عنها بالجملة. وإنما أراد عمر بالكسروية ما كان عليه أهل فارس في ملكهم من ارتكاب الباطل والظلم والبغي وسلوك سبله والغفلة عن الله، وأجابه معاوية بأن القصد بذلك ليس كسروية فارس وباطلهم، وإنما قصده بها وجه الله، فسكت. وهكذا كان شأن الصحابة في رفض الملك وأحواله ونسيان عوائده حذراً من التباسها بالباطل.
فلما استحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر على الصلاة، إذ هي أهم أمور
الدين وارتضاه الناس للخلافة وهي حمل الكافة على أحكام الشريعة، ولم يجر للملك ذكر، لما أنه مظنة للباطل ونحلة يومئذ لأهل الكفر وأعداء الدين. فقام بذلك أبو بكر ما شاء الله متبعاً سنن صاحبه، وقاتل أهل الردة حتى اجتمع العرب على الإسلام.
ثم عهد إلى عمر فاقتفى أثره، وقاتل الأمم فغلبهم، وأذن للعرب في انتزاع ما بأيديهم من الدنيا والملك فغلبوهم عليه، وانتزعوه منهم. ثم صارت إلى عثمان بن عفان، ثم إلى علي رضي الله عنهما، والكل متبرئون من الملك متنكبون على طرقه.
وأكد ذلك لديهم ما كانوا عليه من غضاضة الإسلام وبداوة العرب، فقد كانوا أبعد الأمم عن أحوال الدنيا وترفها، لا من حيث دينهم الذي يدعوهم إلى الزهد في النعيم، ولا من حيث بداوتهم. ومواطنهم، وما كانوا عليه من خشونة العيش وشظفه الذي ألفوه.
فلم تكن أمة من الأمم أسغب عيشاً من مضر لما كانوا بالحجاز في أرض غير ذات زرع ولا ضرع، وكانوا ممنوعين من الأرياف وحبوبها لبعدها واختصاصها بمن وليها من ربيعة واليمن، فلم يكونوا يتطاولون إلى خصبها ولقد كانوا كثيراً ما يأكلون العقارب والخنافس، ويفخرون بأكل العلهز وهو وبر الإبل يمهونه بالحجارة في الدم ويطبخونه. وقريباً من هذا كانت حال قريش في مطاعمهم ومساكنهم.
حتى إذا اجتمعت عصبية العرب على الدين بما أكرمهم الله من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم زحفوا إلى أمم فارس والروم، وطلبوا ما كتب الله لهم من الأرض بوعد الصدق. فابتزوا ملكهم واستباحوا دنياهم، فزخرت بحار الرفه لديهم، حتى كان الفارس الواحد يقسم له في بعض الغزوات ثلاثون ألفاً من الذهب أو نحوها. فاستولوا من ذلك على ما لا يأخذه الحصر. وهم مع ذلك على خشونة عيشهم، فكان عمر يرقع ثوبه بالجلد، وكان علي يقول: " يا صفراء وبا بيضاء غري غيري " . وكان أبو موسى يتجافى عن أكل الدجاج لأنه لم يعهدها للعرب لقلتها يومئذ. وكانت المناخل مفقودة عندهم بالجملة، وإنما كانوا يأكلون الحنطة بنخالها. ومكاسبهم مع هذا أتم ما كانت لأحد من أهل العالم.
قال المسعودي: في أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال، فكان له يوم قتل عند خازنه خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف درهم، وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائة ألف دينار، وخلف إبلاً وخيلاً كثيرة. وبلغ الثمن الواحد من متروك الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينار، وخفف ألف فرس وألف أمة. وكان غلة طلحة من العراق ألف دينار كل يوم، ومن ناحية السراة أكثر من ذلك. وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف ألف فرس، وله ألف بعير وعشرة ألاف من الغنم، وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاً. وخلف زيد بن ثابت من الفضة والذهب ما كان يكسر بالفؤوس، غير ما خلف من الأموال والضياع بمائة ألف دينار. وبنى الزبير داره بالبصرة وكذلك بنى بمصر والكوفة والإسكندرية. وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة وشيد داره بالمدينة وبناها بالجص والآجر والساج. وبنى سعد بن أبي وقاص داره بالعقيق، ورفع سمكها وأوسع فضاءها وجعل على أعلاها شرفات. وبني المقداد داره بالمدينة وجعلها مجصصة الظاهر والباطن وخلف يعلى بن منبه خمسين ألف دينار وعقاراً وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة ألف درهم. كلام المسعودي.
فكانت مكاسب القوم كما تراه، ولم يكن ذلك منعياً عليهم في دينهم، إذ هي أموال لأنها غنائم وفيوء، ولم يكن تصرفهم فيها بإسراف، إنما كانوا على قصد في أحوالهم كما قلناه، فلم يكن ذلك بقادح فيهم، وإن كان الاستكثار من الدنيا مذموماً فإنما يرجع إلى ما أشرنا إليه من الإسراف والخروج به عن القصد. وإذا كان حالهم قصداً ونفقاتهم في سبل الحق ومذاهبه كان ذلك الاستكثار عوناً لهم على طرق الحق واكتساب الدار الأخرة. فلما تدرجت البداوة والغضاضة إلى نهايتها، وجاءت طبيعة الملك التي هي مقتضى العصبية كما قلناه، وحصل التغلب والقهر كان حكم ذلك الملك عندهم حكم ذلك الرفه والاستكثار من الأموال، فلم يصرفوا ذلك التغلب في باطل ولا خرجوا به عن مقاصد الديانة ومذاهب الحق.
ولما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية وهي مقتضى العصبية كان طريقهم فيها الحق والاجتهاد، ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد، كما قد يتوهمه متوهم وينزع إليه ملحد. وإنما اختلف اجتهادهم في الحق وسفه كل واحد نظر صاحبه باجتهاد في الحق فاقتتلوا عليه. وإن كان المصيب علياً فلم يكن معاوية قائماً فيها بقصد الباطل، إنما قصد الحق وأخطأ. والكل كانوا في مقاصدهم على حق.
ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد، واستئثار الواحد به. ولم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها، واستشعرته بنو أمية، ومن لم يكن على طريقة معاوية في اقتفاء الحق من أتباعهم فاعصوصبوا عليه، واستماتوا دونه. ولم حملهم معاوية على غير تلك الطريقة وخالفهم في الانفراد بالأمر لوقع في افتراق الكلمة التي كان جمعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه كبير مخالفة. وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول إذا رأى القاسم بن محمد بن أبي بكر: " لو كان لي من الأمر شيء لوليته الخلافة ولو أراد أن يعهد إليه لفعل، ولكنه كان يخشى من بني أمية أهل الحل والعقد لما ذكرناه، فلا يقدر أن يحول الأمر عنهم، لئلا تقع الفرقة. وهذا كله إنما حمل عليه منازع الملك التي هي مقتضى العصبية. فالملك إذا حصل وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب الحق ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه. ولقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات الله عليهما بملك بني إسرائيل لما اقتضته طبيعة الملك فيهم من الانفراد به، وكانوا ما علمت من النبوة والحق. وكذلك عهد معاوية إلى يزيد خوفاً من افتراق الكلمة بما كانت بنو أمية لم يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم. فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه، مع أن ظنهم كان به صالحاً، ولا يرتاب أحد في ذلك، ولا يظن بمعاوبة غيره، فلم يكن ليعهد إليه، وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق، حاشا لله لمعاوية من ذلك.
وكذلك كان مروان بن الحكم وابنه وإن كانوا ملوكاً فلم يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغي، إنما كانوا متحرين لمقاصد الحق جهدهم إلا في ضرورة تحملهم على بعضها مثل خشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديهم من كل مقصد. يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء، وما علم السلف من أحوالهم ومقاصدهم فقد احتج مالك في الموطإ بعمل عبد الملك.
وأما مروان فكان من الطبقة الأولى من التابعين، وعدالتهم معروفة. ثم تدرج الأمر في ولد عبد الملك، وكانوا من الدين بالمكان الذي كانوا عليه. وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فنزع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة جهده، ولم يهمل. ثم جاء خلفهم واستعملوا طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحري القصد فيها واعتماد الحق في مذاهبها. فكان ذلك مما دعا الناس إلى أن نعوا عليهم أفعالهم وأدالوا بالدعوة العباسية منهم. وولي رجالها الأمر فكانوا من العدالة بمكان، وصرفوا الملك في وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعوا، حتى جاء بنو الرشيد من بعده فكان منهم الصالح والطالح. ثم أفضى الأمر إلى بنيهم فأعطوا الملك والترف حقه، وانغمسوا في الدنيا وباطلها، ونبذوا الدين وراءهم ظهرياً، فتأذن الله بحربهم، وانتزاع الأمر من أيدي العرب جملة، وأمكن سواهم منه. والله لا يظلم مثقال ذرة.
ومن تأمل سير هؤلاء الخلفاء والملوك واختلافهم في تحري الحق من الباطل علم صحة ما قلناه. وقد حكى المسعودي مثله في أحوال بني أمية عن أبي جعفر المنصور، وقد حضر عمومته وذكروا بني أمية فقال: " أما عبد الملك فكان جباراً لا يبالي بما صنع، وأما سليمان فكان همه بطنه وفرجه، وأما عمر فكان أعور بين عميان، وكان رجل القوم هشام " . قال: ولم يزل بنو أمية ضابطين لما مهد لهم من السلطان يحوطونة ويصونون ما وهب الله لهم منه، مع تسنمهم معالي الأمور، ورفضهم دنياتها، حتى أفضى الأمر إلى أبنائهم المترفين، فكانت همتهم قصد الشهوات، وركوب اللذات من معاصي الله جهلاً باستدراجه وأمناً لمكره، مع اطراحهم صيانة الخلافة، واستخفافهم بحق الرياسة وضعفهم عن السياسة، فسلبهم الله العز وألبسهم الذل، ونفى عنهم النعمة " . ثم استحضر عبد الله بن مروان فقص عليه خبره مع ملك النوبة لما دخل أرضهم فاراً أيام السفاح، قال: " أقمت ملياً ثم أتاني ملكهم فقعد على الأرض وقد بسطت له فرش ذات قيمة، فقلت له ما منعك من القعود على ثيابنا؟ فقال: إني ملك! وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه الله. ثم قال: لم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم في كتابكم؟ فقلت: اجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم! قال: فلم تطؤون الزرع بدوابكم والفساد محرم عليكم، قلت: فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم! قال: فلم تلبسون الديباج والذهب والحرير وهو محرم عليكم في كتابكم؟ قلت: ذهب منا الملك وانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا. فأطرق ينكت بيده في الأرض ويقول: عبيدنا وأتباعنا وأعاجم دخلوا في ديننا ثم رفع رأسه إلي وقال: " ليس كما ذكرت! بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله عليكم، وأتيتم ما عنه نهيتم، وظلمتم فيما ملكتم، فسلبكم الله العز وألبسكم الذل بذنوبكم. ولله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم. وأنا خائف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فينالني معكم. وإنما الضيافة ثلاث. فتزود ما احتجت إليه وارتحل عن أرضي. فتعجب المنصور وأطرق.
فقد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك، وأن الأمر كان في أوله خلافة، ووازع كل أحد فيها من نفسه وهو الدين، وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم دون الكافة. فهذا عثمان لما حصر في الدار جاءه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وابن جعفر وأمثالهم يريدون المدافعة عنه، فأبى ومنع من سل السيوف بين المسلمين مخافة الفرقة وحفظاً للألفة التي بها حفظ الكلمة، ولو أدى إلى هلاكه. وهذا علي أشار عليه المغيرة لأول ولايته باستبقاء الزبير ومعاوية وطلحة على أعمالهم حتى يجتمع الناس على بيعته، وتتفق الكلمة، وله بعد ذلك ما شاء من أمره، وكان ذلك من سياسة الملك فأبى فراراً من الغش الذي ينافيه الإسلام. وغدا عليه المغيرة من الغداة فقال: لقد أشرت عليك بالأمس بما أشرت ثم عدت إلى نظري فعلمت أنه ليس من الحق والنصيحة، وأن الحق فيما رأيته أنت، فقال علي: لا والله، بل أعلم أنك نصحتني بالأمس وغششتني اليوم. ولكن منعني مما أشرت به ذائد الحق. وهكذا كانت أحوالهم في اصطلاح دينهم بفساد دنياهم ونحن:
نرقع دنيانا بتمزيق ديننا ... فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع
فقد رأيت كيف صار الأمر إلى الملك وبقيت معاني الخلافة من تحري الدين ومذاهبه والجري على منهاج الحق، ولم يظهر التغير إلا في الوازع الذي كان ديناً ثم انقلب عصبية وسيفاً. وهكذا كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك، والصدر الأول من خلفاء بني العباس إلى الرشيد وبعض ولده. ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا اسمها، وصار الأمر ملكاً بحتاً، وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها، واستعملت في أغراضها من القهر والتقلب في الشهوات والملاذ. وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك، ولمن جاء بعد الرشيد من بني العباس، واسم الخلافة باقياً فيهم لبقاء عصبية العرب. والخلافة والملك في الطورين ملتبس بعضها ببعض. ثم ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم وتلاشي أحوالهم، وبقي الأمر ملكا بحتاً كما كان الشأن في ملوك العجم بالمشرق، يدينون بطاعة الخليفة تبركاً، والملك بجميع ألقابه ومناحيه لهم، وليس للخليفة منه شيء. وكذلك فعل ملوك زناتة بالمغرب مثل صنهاجة مع العبيديين، ومغراوة وبني يفرن أيضاً مع خلفاء بني أمية بالأندلس، والعبيديين بالقيروان. فقد تبين أن الخلافة قد وجدت بدون الملك أولاً، ثم التبست معانيهما واختلطت، ثم انفرد الملك، حيث افترقت عصبيته من عصبية الخلافة. والله مقدر الليل والنهار، وهو الواحد القهار.
الفصل التاسع والعشرون
في معنى البيعة
اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمرنفسه وأمور المسلمين، لا ينازغه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسمي بيعة، مصدر باع، وصارت البيعة مصافحة بالأيدي. هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع، وهو المراد في الحديث في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وعند الشجرة، وحيثما ورد هذا اللفظ، ومنه بيعة الخلفاء. ومنه أيمان البيعة. كان الخلفاء يستحلفون على العهد ويستوعبون الأيمان كلها لذلك، فسمي هذا الاستيعاب أيمان البيعة، وكان الإكراه فيها أكثر وأغلب. ولهذا لما أفتى مالك رضي الله عنه بسقوط يمين الإكراه أنكرها الولاة عليه، ورأوها قادحة في أيمان البيعة، ووقع ما وقع من محنة الإمام رضي الله عنه.وأما البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تحية الملوك الكسروية من تقبيل الأرض أو اليد أو الرجل أو الذيل، أطلق عليها اسم البيعة التي هي العهد على الطاعة مجازاً لما كان هذا الخضوع في التحية، والتزام الأداب، من لوازم الطاعة وتوابعها، وغلب فيه حتى صارت حقيقة عرفية واستغني بها عن مصافحة أيدي الناس التي هي الحقيقة في الأصل، لما في المصافحة لكل أحد من التنزل والابتذال المنافيين للرياسة، وصون المنصب الملوكي، إلا في الأقل ممن يقصد التواضع من الملوك، فيأخذ به نفسه مع خواصه ومشاهير أهل الدين من رعيته. فافهم معنى البيعة في العرف، فإنه أكيد على الإنسان معرفته لما يلزمه من حق سلطانه وإمامه، ولا تكون أفعاله عبثاً ومجاناً، واعتبر ذلك من أفعالك مع الملوك. والله القوي العزيز.
الفصل الثلاثون
في ولاية العهد
اعلم أنا قدمنا الكلام في الإمامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة، وأن حقيقتها النظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم، فهو وليهم والأمين عليهم ينظر لهم ذلك في حياته، ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته، ويقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاها، ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل. وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده إذ وقع بعهد أبي بكر رضي الله لعمر بمحضر من الصحابة وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضي الله عنه وعنهم.وكذلك عهد عمر في الشورى إلى الستة: بقية العشرة، وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين ففوض بعضهم إلى بعض، حتى أفضى ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف، فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متفقين على عثمان وعلى علي، فآثر عثمان بالبيعة على ذلك لموافقته إياه على لزوم الأقتداء بالشيخين في كل ما يعن دون اجتهاده، فانعقد أمر عثمان لذلك وأوجبوا طاعته. والملأ من الصحابة حاضرون للأولى والثانية، ولم ينكره أحد منهم. فدل على أنهم متفقون على صحة هذا العهد عارفون بمشروعيته، والإجماع حجة كما عرف.
ولا يتهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه لأنه مأمون على النظر لهم في حياته، فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد مماته، خلافاً لمن قال باتهامه في الولد والوالد، أو لمن خصص التهمة بالولد دون الوالد، فإنه بعيد عن الظنة في ذلك كله، لا سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه، من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة فتنتفي الظنة عند ذلك رأساً، كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيد، وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب. والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس، واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية، إذ بنو أمية يومئذ، لا يرضون سواهم، وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع، وأهل الغلب منهم. فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها، وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصاً على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع، وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك.
وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه، فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة، وليس معاوية ممن تأخذة العزة في قبول الحق، فإنهم كلهم أجل من ذلك، وعدالتهم مانعة منه. وفرار عبد الله بن عمر من ذلك إنما هو محمول على تورعه من الدخول في شيء من الأمور مباحاً كان أو محظوراً، كما هو معروف عنه. ولم يبق في المخالفة لهذا العهد الذي اتفق عليه الجمهور إلا ابن الزبير، وندور المخالف معروف. ثم إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به مثل عبد الملك وسليمان من بني أمية، والسفاح والمنصور والمهدي والرشيد من بني العباس، وأمثالهم ممن عرفت عدالتهم وحسن رأيهم للمسلمين، والنظر لهم، ولا يعاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم، وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك، فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء، فإنهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك، وكان الوازع دينياً، فعند كل أحد وازع من نفسه، فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقط وآثروه على غيره، ووكلوا كل من يسمو إلى ذلك إلى وازعه، وأما من بعدهم من لدن معاوية فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها من الملك، والوازع الديني قد ضعف واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصباني. فلو عهد إلى غير من ترتضيه العصبية لردت ذلك العهد وانتقض أمره سريعاً وصارت الجماعة إلى الفرقة والاختلاف.
سأل رجل علياً رضي الله عنه: ما بال المسلمين اختلفوا ا عليك، ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر، فقال: لأن أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي وأنا اليوم وال على مثلك، يشير إلى وازع الدين. أفلا ترى إلى المأمون لما عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق وسماه الرضا كيف أنكرت العباسية ذلك، ونقضوا بيعته وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي، وظهر من الهرج والخلاف وانقطاع السبل وتعدد الثوار والخوارج ما كاد أن يصطلم الأمر حتى بادر المأمون من خراسان إلى بغداد ورد أمرهم لمعاهده، فلا بد من اعتبار ذلك في العهد، فالعصور تختلف باختلاف ما يحدث فيها من الأمور والقبائل والعصبيات، وتختلف باختلاف المصالح ولكل واحد منها حكم يخصه، لطفاً من الله بعباده.
وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الأبناء فليس من المقاصد الدينية إذ هو أمر من الله يخص به من يشاء من عباده، ينبغي أن تحسن فيه النية ما أمكن خوفاً من العبث بالمناصب الدينية. والملك لله يؤتيه من يشاء.
وعرض هنا أمور تدعو الضرورة إلى بيان الحق فيها:
فالأول منها ما حدث في يزيد من الفسق أيام خلافته. فإياك أن تظن بمعاوية رضي الله عنه أنه علم ذلك من يزيد، فإنه أعدل من ذلك وأفضل، بل كان يعذله أيام حياته في سماع الغناء وينهاه عنه، وهو أقل من ذلك، وكانت مذاهبهم فيه مختلفة. ولما حدث في يزيد ما حدث من الفسق اختلف الصحابة حينئذ في شأنه. فمنهم من رأى الخروج عليه ونقض بيعته من أجل ذلك، كما فعل الحسين وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ومن اتبعهما في ذلك، ومنهم من أباه لما فيه من إثارة الفتنة وكثرة القتل مع العجز عن الوفاء به لأن شوكة يزيد يومئذ هي عصابة بني أمية وجمهور أهل الحل والعقد من قريش، وتستتبع عصبية مضر أجمع، وهي أعظم من كل شوكة، ولا تطاق مقاومتهم، فأقصروا عن يزيد بسبب ذلك، وأقاموا على الدعاء بهدايته والراحة منه، وهذا كان شأن جمهور المسلمين. والكل مجتهدون ولا ينكر على أحد من الفريقين، فمقاصدهم في البر وتحري الحق معروفة وفقنا الله للاقتداء بهم.
والأمر الثاني هو شأن العهد من النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعيه الشيعة من وصيته لعلي رضي الله عنه. وهو أمر لم يصح ولا نقله أحد من أئمة النقل والذي وقع في الصحيح من طلب الدواة والقرطاس ليكتب الوصية وأن عمر منع من ذلك فدليل واضح على أنه لم يقع، وكذا قول عمر رضي الله عنه حين طعن وسئل في العهد فقال: أن أعهد لقد عهد من هو خير مني يعني أبا بكر، وأن أترك فقد ترك من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد. وكذلك قول علي للعباس رضي الله عنهما حين دعاه للدخول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن شأنهما في العهد، فأبى علي من ذلك وقال: إنه إن منعنا منها فلا نطمع فيها آخر الدهر، وهذا دليل على أن علياً علم أنه لم يوص ولا عهد إلى أحد. وشبهة الإمامية في ذلك إنما هي كون الإمامة من أركان الدين كما يزعمون، وليس كذلك، وإنما هي من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق. ولو كانت من أركان الدين لكان شأنها شأن الصلاة، ولكان يستخلف فيها كما استخلف أبا بكر في الصلاة، ولكان يشتهر كما اشتهر أمر الصلاة.
واحتجاج الصحابة على خلافة أبي بكر بقياسها على الصلاة في قولهم ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، دليل على أن الوصية لم تقع. ويدل ذلك أيضاً على أن أمر الإمامة والعهد بها لم يكن مهماً كما هو اليوم، وشأن العصبية المراعاة في الاجتماع والافتراق في مجاري العادة لم يكن يومئذ بذلك الاعتبار، لأن أمر الدين والإسلام كان كله بخوارق العادة من تأليف القلوب عليه، واستماتة الناس دونه، وذلك من أجل الأحوال التي كانوا يشاهدونها في حضور الملائكة لنصرهم، وتردد خبر السماء بينهم وتجدد خطاب الله في كل حادثة تتلى عليهم. فلم يحتج إلى مراعاة العصبية لما شمل الناس من صبغة الانقياد والإذعان، وما يستفزهم من تتابع المعجزات الخارقة والأحوال الإلهية الواقعة، والملائكة المترددة التي وجموا منها، ودهشوا من تتابعها.
فكان أمر الخلافة والملك والعهد والعصبية، وسائر هذه الأنواع مندرجاً في ذلك القبيل، كما وقع. فلما انحصر ذلك المدد بذهاب تلك المعجزات، ثم بفناء القرون الذين شاهدوها، فاستحالت تلك الصبغة قليلاً قليلاً وذهبت الخوارق وصار الحكم للعادة كما كان. فاعتبر أمر العصبية ومجاري العوائد فيما ينشأ عنها من المصالح والمفاسد، وأصبح الملك والخلافة والعهد بهما مهماً من المهمات الأكيدة كما زعموا، ولم يكن ذلك من قبل.
فانظر كيف كانت الخلافة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم غير مهمة، فلم يعهد فيها. ثم تدرجت الأهمية زمان الخلافة بعض الشيء بما دعت الضرورة إليه في الحماية والجهاد وشأن الردة والفتوحات، فكانوا بالخيار في الفعل والترك كما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه. ثم صارت اليوم من أهم الأمور للألفة على الحماية، والقيام بالمصالح، فاعتبرت فيها العصبية التي هي سر الوازع عن الفرقة والتخاذل، ومنشأ الاجتماع والتوافق، الكفيل بمقاصد الشريعة وأحكامها.
والأمر الثالث شأن الحروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة والتابعين. فاعلم أن اختلافهم إنما يقع في الأمور الدينية وينشأ عن الاجتهاد في الأدلة الصحيحة والمدارك المعتبرة، والمجتهدون إذا اختلفوا: فإن قلنا أن الحق في المسائل الاجتهادية واحد من الطرفين، ومن لم يصادفه فهو مخطىء، فإن جهته لا تتعين بإجماع، فيبقى الكل على احتمال الإصابة، ولا يتعين المخطىء منها، والتأثيم مدفوع عن الكل إجماعاً، وإن قلنا أن الكل على حق وأن كل مجتهد مصيب، فأحرى بنفي الخطإ والتأثيم. وغاية الخلاف الذي بين الصحابة والتابعين أنه خلاف اجتهادي في مسائل دينية ظنية. وهذا حكمه. والذي وقع من ذلك في الإسلام إنما هو واقعة علي مع معاوية ومع الزبير وعائشة وطلحة، وواقعة الحسين مع يزيد، وواقعة ابن الزبير مع عبد الملك: فأما واقعة علي فإن الناس كانوا عند مقتل عثمان مفترقين في الأمصار، فلم يشهدوا بيعة علي. والذين شهدوا فمنهم من بايع ومنهم من توقف حتى يجتمع الناس ويتفقوا على إمام كسعد وسعيد، وابن عمر، وأسامة بن زيد، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن سلام، وقدامة بن مظعون، وأبي سعيد الخدري، وكعب بن عجرة، وكعب بن مالك، والنعمان بن بشير، وحسان بن ثابت، ومسلمة بن مخلد، وفضالة بن عبيد وأمثالهم من أكابر الصحابة. والذين كانوا في الأمصار عدلوا عن بيعته أيضاً إلى الطلب بدم عثمان وتركوا الأمر فوضى، حتى يكون شورى بين المسلمين لمن يولونه. وظنوا بعلي هوادة في السكوت عن نصر عثمان من قاتليه، لا في الممالأة عليه، فحاش لله من ذلك. ولقد كان معاوية إذا صرح بملامته إنما يوجهها عليه في سكوته فقط. ثم اختلفوا بعد ذلك، فرأى علي أن بيعته قد انعقدت، ولزمت من تأخر عنها، باجتماع من اجتمع عليها بالمدينة: دار النبي صلى الله عليه وسلم وموطن الصحابة، وأرجأ الأمر في المطالبة بدم عثمان إلى اجتماع الناس واتفاق الكلمة، فيتمكن حينئذ من ذلك. ورأى الأخرون أن بيعته لم تنعقد لافتراق الصحابة أهل الحل والعقد بالأفاق، ولم يحضر إلا قليل ولا تكون البيعة إلا باتفاق أهل الحل والعقد، ولا تلزم بعقد من تولاها من غيرهم أو من القليل منهم، وأن المسلمين حينئذ فوضى، فيطالبون أولاً بدم عثمان ثم يجتمعون على إمام. وذهب إلى هذا معاوية وعمرو بن العاص وأم المؤمنين عائشة والزبير وابنه عبد الله، وطلحة وابنه محمد، وسعد وسعيد، والنعمان بن بشير ومعاوية بن خديج، ومن كان على رأيهم من الصحابة الذين تخلفوا عن بيعة علي بالمدينة كما ذكرنا. إلا أن أهل العصر الثاني من بعدهم اتفقوا على انعقاد بيعة علي ولزومها للمسلمين أجمعين، وتصويب رايه فيما ذهب إليه، وتعين الخطإ من جهة معاوية ومن كان على رأيه، وخصوصاً طلحة والزبير لانتقاضهما على علي بعد البيعة له فيما نقل، مع دفع التأثيم عن كل من الفريقين، كالشأن في المجتهدين. وصار ذلك إجماعاً من أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، كما هو معروف. ولقد سئل علي رضي الله عنه عن قتلى الجمل وصفين، فقال: " والذي نفسي بيده لا يموتن أحد من هؤلاء وقلبه نقي إلا دخل الجنة " يشير إلى الفريقين، نقله الطبري وغيره. فلا يقعن عندك ريب في عدالة أحد منهم ولا قدح في شيء من ذلك، فهم من علمت، وأقوالهم وأفعالهم إنما هي عن المستندات، وعدالتهم مفروغ منها عند أهل السنة، إلا قولاً للمعتزلة فيمن قاتل علياً لم يلتفت إليه أحد من أهل الحق ولا عرج عليه.
وإذا نظرت بعين الإنصاف عذرت الناس أجمعين في شأن الاختلاف في عثمان، واختلاف الصحابة من بعد، وعلمت أنها كانت فتنة ابتلى الله بها الأمة، بينما المسلمون قد أذهب الله عدوهم وملكهم أرضهم وديارهم، ونزلوا الأمصار على حدودهم بالبصرة والكوفة والشام ومصر. وكان أكثر العرب الذين نزلوا هذه الأمصار جفاة لم يستكثروا من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذبتهم سيرته وآدابه ولا ارتاضوا بخلقه، مع ما كان فيهم في الجاهلية من الجفاء والعصبية والتفاخر والبعد عن سكينة الإيمان. وإذا بهم عند استفحال الدولة قد أصبحوا في ملكة المهاجرين والأنصار من قريش وكنانة وثقيف وهذيل وأهل الحجاز ويثرب السابقين الأولين إلى الإيمان، فاستنكفوا من ذلك وغضوا به، لما يرون لأنفسهم من التقدم بأنسابهم وكثرتهم، ومصادمة فارس والروم مثل قبائل بكر بن وائل وعبد القيس بن ربيعة وقبائل كندة والأزد من اليمن وتميم، وقيس من مضر. فصاروا إلى الغض من قريش والأنفة عليهم، والتمريض في طاعتهم، والتعلل في ذلك بالتظلم منهم والاستعداء عليهم، والطعن فيهم بالعجز عن السوية، والعدل في القسم عن التسوية، وفشت المقالة بذلك، وانتهت إلى المدينة، وهم من علمت. فأعظموه وأبلغوه عثمان، فبعث إلى الأمصار من يكشف له الخبر. بعث ابن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأمثالهم فلم ينكروا على الأمراء شيئاً ولا رأوا عليهم طعناً، وأدوا ذلك كما علموه. فلم ينقطع الطعن من أهل الأمصار. وما زالت الشناعات تنمو. ورمي الوليد بن عقبة وهو على الكوفة بشرب الخمر، وشهد عليه جماعة منهم وحده عثمان وعزله. ثم جاء إلى المدينة من أهل الأمصار يسألون عزل العمال، وشكوا إلى عائشة وعلي والزبير وطلحة، وعزل لهم عثمان بعض العمال. فلم تنقطع بذلك ألسنتهم، بل وفد سعيد بن العاص وهو على الكوفة، فلما رجع اعترضوة بالطريق وردوه معزولاً. ثم انتقل الخلاف بين عثمان ومن معه من الصحابة بالمدينة ونقموا عليه امتناعه عن العزل، فأبى إلا أن يكون على جرحة. ثم نقلوا النكير إلى غير ذلك من أفعاله وهو متمسك بالاجتهاد، وهم أيضاً كذلك. ثم تجمع قوم من الغوغاء وجاؤوا إلى المدينة يظهرون طلب النصفة من عثمان وهم يضمرون خلاف ذلك من قتله. وفيهم من البصرة والكوفة ومصر. وقام معهم في ذلك علي وعائشة والزبير وطلحة وغيرهم، يحاولون تسكين الأمور ورجوع عثمان إلى رأيهم. وعزل لهم عامل مصر فانصرفوا قليلاً. ثم رجعوا وقد لبسوا بكتاب مدلس يزعمون أنهم لقوه في يد حامله إلى عامل مصر بأن يقتلهم، وحلف عثمان على ذلك، فقالوا: مكنا من مروان فإنه كاتبك، فحلف مروان، فقال عثمان ليس في الحكم أكثر من هذا. فحاصروه بداره ثم بيتوه على حين غفلة من الناس وقتلوه، وانفتح باب الفتنة.
فلكل من هؤلاء عذر فيما وقع وكلهم كانوا مهتدين بأمر الدين ولا يضيعون شيئاً من تعلقاته. ثم نظروا بعد هذا الواقع واجتهدوا. والله مطلع على أحوالهم وعالم بهم. ونحن لا نظن بهم إلا خيراً لما شهدت به أحوالهم، ومقالات الصادق فيهم.
مقتل الحسين بن عليوأما الحسين فإنه لما ظهر فسق يزيد عند الكافة من أهل عصره، بعثت شيعة أهل البيت بالكوفة للحسين أن يأتيهم فيقوموا بأمره. فرأى الحسين أن الخروج على يزيد متعين من أجل فسقه لا سيما من له القدرة على ذلك، وظنها من نفسه بأهليته وشوكته. فأما الأهلية فكانت كما ظن وزيادة. وأما الشوكة فغلط يرحمه الله فيها لأن عصبية مضر كانت في قريش وعصبية قريش في عبد مناف، وعصبية عبد مناف إنما كانت في بني أمية، تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس، ولا ينكرونه وإنما نسي ذلك أول الإسلام لما شغل الناس من الذهول بالخوارق، وأمر الوحي وتردد الملائكة لنصرة المسلمين. فأغفلوا أمور عوائدهم وذهبت عصبية الجاهلية ومنازعها ونسيت، ولم يبق إلا العصبية الطبيعية في الحماية والدفاع ينتفع بها في إقامة الدين وجهاد المشركين، والدين فيها محكم والعادة معزولة. حتى إذا انقطع أمر النبوة والخوارق المهولة تراجع الحكم بعض الشيء للعوائد، فعادت العصبية كما كانت ولمن كانت، وأصبحت مضر أطوع لبني أمية من سواهم بما كان لهم من ذلك قبل.
فقد تبين لك غلط الحسين، إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه. وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه لأنه منوط بظنه، وكان ظنه القدرة على ذلك. ولقد عذله ابن العباس وابن الزبير وابن عمر وابن الحنفية أخوه وغيره في مسيره إلى الكوفة، وعلموا غلطه في ذلك ولم يرجع عما هو بسبيله لما أراده الله.
وأما غير الحسين من الصحابة الذين كانوا بالحجاز ومع يزيد بالشام، والعراق ومن التابعين لهم، فرأوا أن الخروج على يزيد وإن كان فاسقاً لا يجوز لما ينشأ عنه من الهرج والدماء فأقصروا عن ذلك ولم يتابعوا الحسين، ولا أنكروا عليه، ولا أثموه، لأنه مجتهد وهو أسوة المجتهدين.
ولا يذهب بك الغلط أن تقول بتأثيم هؤلاء بمخالفة الحسين وقعودهم عن نصره، فإنهم أكثر الصحابة وكانوا مع يزيد ولم يروا الخروج عليه، وكان الحسين يستشهد بهم وهو يقاتل بكربلاء على فضله وحقه، ويقول: " سلوا جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك، وسهل بن سعيد، وزيد بن أرقم وأمثالهم. ولم ينكر عليهم قعودهم عن نصره ولا تعرض لذلك، لعلمه أنه عن اجتهاد منهم كما كان فعلة عن اجتهاد منه. وكذلك لا يذهب بك الغلط أن تقول بتصويب قتله لما كان عن اجتهاد وإن كان هو على اجتهاد، ويكون ذلك كما يحد الشافعي والمالكي الحنفي على شرب النبيذ. واعلم أن الأمر ليس كذلك وقتاله لم يكن عن اجتهاد هؤلاء وإن كان خلافه عن اجتهادهم، وإنما انفرد بقتاله يزيد وأصحابه. ولا تقولن إن يزيد وإن كان فاسقاً ولم يجز هؤلاء الخروج عليه فأفعاله عندهم صحيحة. واعلم أنه إنما ينفذ من أعمال الفاسق ما كان مشروعاً. وقتال البغاة عندهم من شرطه أن يكون مع الإمام العادل، وهو مفقود في مسألتنا، فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد، بل هي من فعلاته المؤكدة لفسقه، والحسين فيها شهيد مثاب، وهو على حق واجتهاد، والصحابة الذين كانوا مع يزيد على حق أيضاً واجتهاد.
وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذا فقال في كتابه الذي سماه بالعواصم والقواصم ما معناه أن الحسين قتل بشرع جده، وهو غلط حملته عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل، ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الأراء؟!.
وأما ابن الزبير فإنه رأى في قيامه ما رآه الحسين وظن كما ظن، وغلطه في أمر الشوكة أعظم، لأن بني أسد لا يقاومون بني أمية في جاهلية ولا إسلام. والقول بتعين الخطأ في جهة مخالفة كما كان في جهة معاوية مع علي لا سبيل إليه، لأن الإجماع هنالك قضى لنا به ولم نجده ههنا. وأما يزيد فعين خطأه فسقه. وعبد الملك صاحب ابن الزبير أعظم الناس عدالة، وناهيك بعدالته احتجاج مالك بفعله وعدول ابن عباس وابن عمر إلى بيعته عن ابن الزبير وهم معه بالحجاز، مع أن الكثير من الصحابة كانوا يرون أن بيعة ابن الزبير لم تنعقد، لأنه لم يحضرها أهل العقد والحل كبيعة مروان، وابن الزبير على خلاف ذلك، والكل مجتهدون محمولون على الحق في الظاهر، وإن لم يتعين في جهة منهما. والقتل الذي نزل به بعد تقرير ما قررناه يجيء على قواعد الفقه وقوانينه، مع أنه شهيد مثاب باعتبار قصده وتحريه الحق.
هذا هو الذي ينبغي أن تحمل عليه أفعال السلف من الصحابة والتابعين، فهم خيار الأمة، وإذا جعلناهم عرضة للقدح فمن الذي يختص بالعدالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم مرتين أو ثلاثاً ثم يفشو الكذب " ، فجعل الخيرة، وهي العدالة مختصة بالقرن الأول والذي يليه. فإياك أن تعود نفسك أو لسانك التعرض لأحد منهم، ولا تشوش قلبك بالريب في شيء مما وقع منهم، والتمس لهم مذاهب الحق وطرقة ما استطعت فهم أولى الناس بذلك، وما اختلفوا إلا عن بينة، وما قاتلوا أو قتلوا إلا في سبيل جهاد أو إظهار حق، واعتقد مع ذلك أن اختلافهم رحمة لمن بعدهم من الأمة، ليقتدي كل واحد بمن يختاره منهم، ويجعله إمامه وهاديه ودليله. فافهم ذلك، وتبين حكمة الله في خلقه وأكوانه، واعلم أنه على كل شيء قدير وإليه الملجأ والمصير. والله تعالى أعلم.
الفصل الحادي والثلاثون
في الخطط الدينية الخلافية
لما تبين أن حقيقة الخلافة نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا، فصاحب الشرع متصرف في الأمرين: أما في الدين فبمقتضى التكاليف الشرعية التي هو مأمور بتبليغها وحمل الناس عليها، وأما سياسة الدنيا فبمقتضي رعايته لمصالحهم في العمران البشري. وقد قدمنا أن هذا العمران ضروري للبشر وأن رعاية مصالحه كذلك، لئلا يفسد إن أهملت، وقدمنا أن الملك وسطوته كاف في حصول هذه المصالح. نعم إنما تكون أكمل إذا كانت بالأحكام الشرعية لأنه أعلم بهذه المصالح. فقد صار الملك يندرج تحت الخلافة إذا كان إسلامياً ويكون من توابعها. وقد ينفرد إذا كان في غير الملة. وله على كل حال مراتب خادمة ووظائف تابعة تتعين خططاً وتتوزع على رجال الدولة وظائف، فيقوم كل واحد بوظيفته حسبما يعينه الملك الذي تكون يده عالية عليهم، فيتم بذلك أمره، ويحسن قيامه بسلطانه. وأما المنصب الخلافي وإن كان الملك يندرج تحته بهذا الاعتبار الذي ذكرناه فتصرفه الديني يختص بخطط ومراتب لا تعرف إلا للخلفاء الإسلاميين. فلنذكر الآن الخطط الدينية المختصة بالخلافة، ونرجع إلى الخطط الملوكية السلطانية.
فاعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة، فكأنها الإمام الكبير والأصل الجامع، وهذه كلها متفرعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية، وتنفيذ أحكام المشرع فيها على العموم.
فأما إمامة الصلاة فهي أرفع هذه الخطط كلها وأرفع من الملك بخصوصه المندرج معها تحت الخلافة. ولقد يشهد لذلك استدلال الصحابة في شأن أبي بكر رضي الله عنه باستخلافه في الصلاة على استخلافه في السياسة في قولهم: ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فلولا أن الصلاة أرفع من السياسة لما صح القياس. وإذا ثبت ذلك فاعلم أن المساجد في المدينة صنفان: مساجد عظيمة كثيرة الغاشية معدة للصلوات المشهودة، وأخرى دونها مختصة بقوم أو محلة وليست للصلوات العامة. فأما المساجد العظيمة فأمرها راجع إلى الخليفة أو من يفوض إليه من سلطان أو وزير أو قاض، فينصب لها الإمام في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين والخسوفين والاستسقاء. وتعين ذلك إنما هو من طريق الأولى والاستحسان ولئلا يفتات الرعايا عليه في شيء من النظر في المصالح العامة. وقد يقول بالوجوب في ذلك من يقول بوجوب إقامة الجمعة، فيكون نصب الإمام لها عنده واجباً. وأما المساجد المختصة بقوم أو محلة فأمرها راجع إلى الجيران ولا تحتاج إلى نظر خليفة ولا سلطان. وأحكام هذه الولاية وشروطها والمولى فيها معروفة في كتب الفقه ومبسوطة في كتب الأحكام السلطانية للماوردي وغيره، فلا نطول بذكرها. ولقد كان الخلفاء الأولون لا يقلدونها لغيرهم من الناس. وانظر من طعن من إلى خلفاء في المسجد عند الأذان بالصلاة وترصدهم لذلك في أوقاتها، يشهد لك ذلك بمباشرتهم لها وأنهم لم يكونوا يستخلفون بها. وكذا كان رجال الدولة الأموية من بعدهم استئثاراً بها واستعظاماً لرتبتها.
يحكى عن عبد الملك أنه قال لحاجبه: قد جعلت لك حجابة بابي إلا عن ثلائة: صاحب الطعام فإنه يفسد بالتأخير، والآذن بالصلاة فإنه داع إلى الله، والبريد فإن في تأخيره فساد القاصية. فلما جاءت طبيعة الملك وعوارضه من الغلظة والترفع عن مساواة الناس في دينهم ودنياهم، استنابوا في الصلاة، فكانوا يستأثرون بها في الأحيان، وفي الصلوات العامة كالعيدين والجمعة إشادة وتنويهاً. فعل ذلك كثير من خلفاء بني العباس والعبيديين، صدر دولتهم.
وأما الفتيا، فللخليفة، تصفح أهل العلم والتدريس، ورد الفتيا إلى من هو أهل لها وإعانته على ذلك، ومنع من ليس أهلاً لها وزجره، لأنها من مصالح المسلمين في أديانهم، فتجب عليه مراعاتها لئلا يتعرض لذلك من ليس له بأهل فيضل الناس. وللمدرس الانتصاب لتعليم العلم وبثه والجلوس لذلك في المساجد. فإن كانت من المساجد العظام، التي للسلطان الولاية عليها أو النظر فى أئمتها كما مر، فلا بد من استئذانه في ذلك، وإن كانت من مساجد العامة، فلا يتوقف ذلك على إذن. على أنه ينبغي أن يكون لكل أحد من المفتين والمدرسين زاجرمن نفسه يمنعه عن التصدي لما ليس له بأهل فيدل به المستهدي ويضل به المسترشد. وفي الأثر: " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على جراثيم جهنم " . فللسطان فيهم لذلك من النظر ما توجبه المصلحة من إجازة أو رد.
وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع، إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة، فكان لذلك من وظائف الخلافة ومندرجاً في عمومها. وكان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم. وأول من دفعه إلى غيره وفوضه فيه عمر رضي الله عنه فولى أبا الدرداء منه بالمدينة، وولى شريحاً بالبصرة وولى أبا موسى الأشعري بالكوفة. وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاة وهي مستوفاة فيه.
يقول: " أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذله، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. ولا يمنعك قضاء قضيته أمس، فراجعت اليوم فيه عقلك، وهديت فيه لرشدك، أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة. ثم اعرف الأمثال والأشباه، وقس الأمور بنظائرها. واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينة أمداً ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحللت القضية عليه، فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى. المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد، أو مجرباً عليه شهادة زور، أو ظنيناً في نسب أو ولاء، فإن الله سبحانه عفا عن الأيمان، ودرأ بالبينات. وإياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم، فإن استقرار الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذكر والسلام " . انتهى كتاب عمر.
وإنما كانوا يقفدون القضاء لغيرهم وإن كان مما يتعلق بهم، لقيامهم بالسياسة العامة وكثرة أشغالها، من الجهاد والفتوحات وسد الثغور وحماية البيضة، ولم يكن ذلك مما يقوم به غيرهم لعظم العناية. فاستحقوا القضاء في الواقعات بين الناس، واستخلفو فيه من يقوم به تخفيفاً على أنفسهم. وكانوا مع ذلك إنما يقفونه أهل عصبيتهم بالنسب أو الولاء ولا يقلدونه لمن بعد عنهم في ذلك.
وأما أحكام هذا المنصب وشروطه فمعروفة في كتب الفقه، وخصوصاً كتب الأحكام السلطانية. إلا أن القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط، ثم دفع لهم بعد ذلك أمور أخرى على التدريج بحسب اشتغال الخلفاء والملوك بالسياسة الكبرى. واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أموال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه، وفي وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء على رأي من رآه، والنظر في مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشهود والأمناء والنواب، واستيفاء العلم والخبرة فيهم، بالعدالة والجرح ليحصل له الوثوق بهم وصارت هذه كلها من تعلقات وظيفته وتوابع ولايته.
وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالم، وهي وظيفة ممتزجة، من سطوة السلطنة ونصفة القضاء. وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين، وتزجر المعتدي وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه. ويكون نظره في البينات والتقرير واعتماد الأمارات والقرائن، وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق، وحمل الخصمين على الصلح، واستحلاف الشهود وذلك أوسع من نظر القاضي.
وكان الخلفاء الأولون يباشرونها بأنفسهم إلى أيام المهتدي من بني العباس، رربما كانوا يجعلونها لقضاتهم كما فعل عمر رضي الله عنه مع قاضيه أبي إدريس الخولاني، وكما فعله المأمون ليحيى بن أكثم، والمعتصم لأحمد بن أبي دواد. وربما كانوا يجعلون للقاضي قيادة الجهاد في عساكر الطوائف. وكان يحيى بن أكثم يخرج أيام المأمون بالصائفة إلى أرض الروم، وكذا منذر بن سعيد قاضي عبد الرحمن الناصر من بني أمية بالأندلس. فكانت تولية هذه الوظائف إنما تكون للخلفاء أو من يجعلون ذلك له من وزير مفوض أو سلطان متغلب.
وكان أيضاً النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية بالأندلس، والعبيديين بمصر والمغرب، راجعاً إلى صاحب الشرطة، وهي وظيفة آخرى دينية كانت من الوظائف الشرعية في تلك الدول، توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلاً، فيجعل للتهمة في الحكم مجالاً ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم، ويقيم الحدود الثابتة في محالها، ويحكم في القود والقصاص، ويقيم التعزير والتأديب في حق من لم ينته عن الجريمة.
ثم تنوسي شأن هاتين الوظيفتين في المولى التي تنوسي فيها أمر الخلافة، فصار أمر المظالم راجعاً إلى السلطان، كان له تفويض من الخليفة أو لم يكن. وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين: منها وظيفة التهمة على الجرائم، وإقامة حدودها، ومباشرة القطع والقصاص حيث يتعين، ونصب لذلك في هذه الدول حاكم يحكم فيها بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية، ويسمى تارة باسم الوالي، وتارة باسم الشرطة. وبقي قسم التعازير وإقامة الحدود في الجرائم الثابتة شرعاً، فجمع للقاضي مع ما تقدم وصار ذلك من توابع وظيفته وولايته. واستقر الأمر لهذا العهد على ذلك. وخرجت هذه الوظيفة عن أهل عصبية الدولة. لأن الأمر لما كان خلافة دينية، وهذه الخطة من مراسم الدين فكانوا لا يولون فيها إلا من أهل عصبيتهم من العرب مواليهم بالحلف أو بالرق أو بالاصطناع ممن يوثق بكفايته أو غنائه فيما يدفع إليه. ولما انقرض شأن الخلافة وطورها وصار الأمر كله ملكاً أو سلطاناً صارت هذه الخطط الدينية بعيدة عنه بعض الشيء، لأنها ليست من ألقاب الملك ولا مراسمه، ثم خرج الأمر جملة من العرب وصار الملك لسواهم من أمم الترك والبربر، فازدادت هذه الخطط الخلافية بعداً عنهم بمنحاها وعصبيتها. وذلك أن العرب كانوا يرونه أن الشريعة دينهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأحكامه وشرائعه نحلتهم بين الأمم وطريقهم، وغيرهم لا يرون ذلك، إنما يولونها جانباً من التعظيم لما دانوا بالملة فقط. فصاروا يقلدونها من غيرعصابتهم ممن كان تأهل لها في دول الخلفاء السالفة. وكان أولئك المتأهلون لما أخذهم ترف الدول منذ مئين من السنين قد نسوا عهد البداوة وخشونتها، والتبسوا بالحضارة في عوائد ترفهم ودعتهم، وقلة الممانعة عن أنفسهم، وصارت هذه الخطط في المولى الملوكية من بعد الخلفاء مختصة بهذا الصنف من المستضعفين في أهل الأمصار، ونزل أهلها عن مراتب العز لفقد الأهلية بأنسابهم وما هم عليه من الحضارة، فلحقهم من الاحتقار ما لحق الحضر المنغمسين في الترف والدعة، البعداء عن عصبية الملك الذين هم عيال على الحامية، وصار اعتبارهم في الدولة من أجل قيامها بالملة وأخذها بأحكام الشريعة، لما أنهم الحاملون للأحكام المقتدون بها. ولم يكن إيثارهم في الدولة حينئذ إكراماً لذواتهم، وإنما هو لما يتلمح من التجمل بمكانهم في مجالس الملك لتعظيم الرتب الشرعية، ولم يكن لهم فيها من الحل والعقد شيء، وإن حضروه فحضور رسمي لا حقيقة وراءه، إذ حقيقة الحل والعقد إنما هي لأهل القدرة عليه، فمن لا قدرة له عليه فلا حل له ولا عقد لديه. اللهم إلا أخذ الأحكام الشرعية عنهم، وتلقي الفتاوى منهم فنعم. والله الموفق.
وربما يظن بعض الناس أن الحق فيما وراء ذلك، وأن فعل الملوك فيما فعلوه من إخراح الفقهاء والقضاة من الشورى مرجوح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " العلماء ورثة الأنبياء " . فاعلم أن ذلك ليس كما ظنه. وحكم الملك والسلطان إنما يجري على ما تقتضيه طبيعة العمران وإلا كان بعيداً عن السياسة. فطبيعة العمران في هؤلاء لا تقضي لهم شيئاً من ذلك، لأن الشورى والحل والعقد لا تكون إلا لصاحب عصبية يقتدر بها على حل أو عقد أو فعل أو ترك، وأما من لا عصبية له ولا يملك من أمر نفسه شيئاً ولا من حمايتها، وإنما هو عيال على غيره فأي مدخل له في الشورى أو أي معنى يدعو إلى اعتباره فيها؟! اللهم إلا شوراه فيما يعلمه من الأحكام الشرعية فموجودة في الاستفتاء خاصة. وأما شوراه في السياسة فهو بعيد عنها لفقدانه العصبية والقيام على معرفة أحوالها وأحكامها. وإنما إكرامهم من تبرعات الملوك والأمراء الشاهدة لهم بجميل الاعتقاد في الدين وتعظيم من ينتسب إليه بأي جهة انتسب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " العلماء ورثة الأنبياء " ، فاعلم أن الفقهاء في الأغلب لهذا العهد وما احتف به إنما حملوا الشريعة أقوالاً في كيفية الأعمال في العبادات وكيفية القضاء في المعاملات، ينصونها على من يحتاج إلى العمل بها، هذه غاية أكابرهم ولا يتصفون إلا بالأقل منها، وفي بعض الأحوال. والسلف رضوان الله عليهم وأهل الدين والورع من المسلمين حملوا الشريعة اتصافاً بها وتحققاً بمذاهبها. فمن حملها اتصافاً وتحققاً دون نقل فهو من الوارثين، مثل أهل رسالة القشيري.
ومن اجتمع له الأمران فهو العالم وهو الوارث على الحقيقة، مثل فقهاء التابعين والسلف والأئمة الأربعه ومن اقتفى طريقهم، وجاء على آثرهم. وإذا انفرد واحد من الأئمة بأحد الأمرين فالعابد أحق بالوراثة من الفقيه الذي ليس بعابد، لأن العابد ورث بصفة والفقيه الذي ليس بعابد لم يرث شيئاً، إنما هو صاحب أقوال ينصها علينا في كيفيات العمل، وهؤلاء أكثر فقهاء عصرنا، " إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم " .
العدالةوهي وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن مواد تصريفه. وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم، تحملاً عند الإشهاد وأداء عند التنازع، وكتباً في السجلات تحفظ به حقوق الناس وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم. وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من الجرح، ثم القيام بكتب السجلات والعقود من جهة عبارتها وانتظام فصولها، ومن جهة إحكام شروطها الشرعية وعقودها، فيحتاج حينئذ إلى ما يتعلق بذلك من الفقه. ولأجل هذه الشروط وما يحتاج إليه من المران على ذلك والممارسة له اختص ذلك ببعض العدول، وصار الصنف القائمون به كأنهم مختصون بالعدالة، وليس كذلك، وإنما العدالة من شروط اختصاصهم بالوظيفة.
ويجب على القاضي تصفح أحوالهم والكشف عن سيرهم رعاية لشرط العدالة فيهم، وأن لا يهمل ذلك لما يتعيين عليه من حفظ حقوق الناس، فالعهدة عليه في ذلك كله، وهو ضامن دركه. وإذا تعين هؤلاء لهذه الوظيفة عمت الفائدة في تعيين من تخفى عدالته على القضاة بسبب اتساع الأمصار واشتباه الأحوال، واضطرار القضاة إلى الفصل بين المتنازعين بالبينات الموثوقة، فيعولون غالباً في الوثوق بها على هذا الصنف. ولهم في سائر الأمصار دكاكين ومصاطب يختصون بالجلوس عليها فيتعاهدهم أصحاب المعاملات للإشهاد وتقييده بالكتاب.
وصار مدلول هذه اللفظة مشتركاً بين هذه الوظيفة التي تبين مدلولها وبين العدالة الشرعية التي هي أخت الجرح. وقد يتواردان ويفترقان. والله تعالى أعلم.
الحسبة والسكة
أما الحسبة فهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين، يعين لذلك من يراه أهلاً له، فيتعين فرضه عليه، ويتخذ الأعوان على ذلك، ويبحث عن المنكرات، ويعزز ويؤدب على قدرها، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة: مثل المنع من المضايقة في الطرقات، ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل، والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها، وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة، والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرها في الإبلاع في ضربهم للصبيان المتعلمين. ولا يتوقف حكمه على تنازع أو استعداء، بل له النظر والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك، ويرفع إليه. وليس له إمضاء الحكم في الدعاوى مطلقاً بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها، وفي المكاييل والموازين، وله أيضاً حمل المماطلين على الإنصاف، وأمثال ذلك مما ليس فيه سماع بينة، ولا إنفاذ حكم.
وكأنها أحكام ينزه القاضي عنها لعمومها وسهولة أغراضها، فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بها. فوضعها على ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء. وقد كانت في كثير من الدول الإسلامية مثل العبيديين بمصر والمغرب والأمويين بالأندلس داخلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باختياره. ثم لما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة وصار نظره عاماً في أمور السياسة اندرجت في وظائف الملك وأفردت بالولاية.
وأما السكة فهي النظر في النقود المتعامل بها بين الناس، وحفظها مما يداخلها من الغش أو النقص إن كان يتعامل بها عدداً أو ما يتعلق بذلك ويوصل إليه من جميع الاعتبارات، ثم في وضع علامة السلطان على تلك النقود بالاستجادة والخلوص برسم تلك العلامة فيها من خاتم حديد اتخذ لذلك، ونقش فيه نقوش خاصة به، فيوضع على الدينار بعد أن يقدر ويضرب عليه بالمطرقة حتى ترسم فيه تلك النقوش، وتكون علامة على جودته بحسب الغاية التي وقف عندها السبك والتخليص في متعارف أهل القطر ومذاهب الدولة الحاكمة، فإن السبك والتخليص في النقود لا يقف عند غاية، وإنما ترجع غايته إلى الاجتهادة فإذا وقف أهل أفق أو قطر على غاية من التخليص وقفوا عندها وسموها إماماً وعياراً يعتبرون به نقودهم وينتقدونها بمماثلته، فإن نقص عن ذلك كان زيفاً.
والنظر في ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة. وهي دييية بهذا الاعتبار، فتندرج تحت الخلافة. وقد كانت تندرج في عموم ولاية القاضي، ثم أفردت لهذا العهد كما وقع في الحسبة.
هذا آخر الكلام في الوظائف الخلافية، وبقيت منها وظائف ذهبت بذهاب ما ينظر فيه وأخرى صارت سلطانية: فوظيفة الإمارة والوزارة والحرب والخراج صارت سلطانية، نتكلم عليها في أماكنها بعد وظيفة الجهاد، ووظيفة الجهاد بطلت ببطلانه إلا في قليل من الدول يمارسونه ويدرجون أحكامه غالباً في السلطانيات.
وكذا نقابة الأنساب التي يتوصل بها إلى الخلافة أو الحق في بيت المال قد بطلت لدثور الخلافة ورسومها. وبالجملة قد اندرجت رسوم الخلافة ووظائفها في رسوم الملك والسياسة في سائر الدول لهذا العهد. والله مصرف الأمور كيف يشاء.
الفصل الثاني والثلاثون
في اللقب بأمير المؤمنين
وأنه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد الخلفاء وذلك أنه لما بويع أبو بكر رضي الله عنه، كان الصحابة رضي الله عنهم وسائر المسلمين يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن هلك. فلما بويع لعمر بعهده إليه كانوا يدعونه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنهم استثقلوا هذا اللقب بكثرته وطول إضافته وأنه يتزايد فيما بعد دائماً إلى أن ينتهي إلى الهجنة، ويذهب منه التمييز بتعدد الأضافات وكثرتها، فلا يعرف. فكانوا يعدلون عن هذا اللقب إلى ما سواه مما يناسبه ويدعى به مثله. وكانوا يسمون قواد البعوث باسم الأمير وهو فعيل من الإمارة. وقد كان الجاهلية يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أمير مكة وأمير الحجاز، وكان الصحابة أيضاً يدعون سعد بن أبي وقاص أمير المؤمنين لإمارته على جيش القادسية، وهم معظم المسلمين يومئذ.واتفق أن دعا بعض الصحابة عمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به، يقال: أن أول من دعاه بذلك عبد الله بن جحش، وقيل: عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة، وقيل: بريد جاء بالفتح من بعض البعوث ودخل المدينة وهو يسأل عن عمر ويقول أين أمير المؤمنين، وسمعها اصحابه فاستحسنوه، وقالوا أصبت والله اسمه، إنه والله أمير المؤمنين حقاً، فدعوه بذلك، وذهب لقباً له في الناس. وتوارثه الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم سائر دولة بني أمية. ثم أن الشيعة خصوا علياً باسم الإمام نعتاً له بالإمامة التي هي أخت الخلافة، وتعريضاً بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر لما هو مذهبهم وبدعتهم، فخصوه بهذا الفقب ولمن يسوقون إليه منصب الخلافة من بعده فكانوا كلهم يسمون بالإمام ما داموا يدعون لهم في الخفاء، حتى إذا يستولون على الدولة يحولون اللقب فيمن بعده إلى أمير المؤمنين، كما فعله شيعة بني العباس، فإنهم ما زالوا يدعون أئمتهم بالإمام إلى إبراهيم الذي جهروا بالدعاء له، وعقدوا الرايات للحرب على أمره، فلما هلك دعي أخوه السفاح بأمير المؤمنين. وكذا الرافضة بإفريقية فإنهم ما زالوا يدعون أئمتهم من ولد إسماعيل بالإمام، حتى انتهى الأمر إلى عبيد الله المهدي وكانوا أيضاً يدعونه بالإمام، ولابنه أبي القاسم من بعده. فلما استوثق لهم الأمر دعوا من بعدهما بأمير المؤمنين. وكذا الأدارسة بالمغرب كانوا يلقبون إدريس بالإمام، وابنه إدريس الأصغر كذلك، وهكذا شأنهم.
وتوارث الخلفاء هذا اللقب بأمير المؤمنين، وجعلوه سمة لمن يملك الحجاز والشام والعراق: المواطن التي هي ديار العرب، ومراكز الدولة وأهل الملة والفتح. وازداد كذلك في عنفوان الدولة وبذخها لقب آخر للخلفاء يتميز بعضهم عن بعض لما في أمير المؤمنين من الاشتراك بينهم، فاستحدث ذلك بنو العباس، حجاباً، لأسمائهم الأعلام، عن امتهانها في السنة السوقة وصوناً لها عن الابتذال، فتلقبوا بالسفاح والمنصور والمهدي والهادي والرشيد إلى آخر الدولة. واقتفى آثرهم في ذلك العبيديون بإفريقية ومصر، وتجافى بنو أمية عن ذلك في المشرق قبلهم من الغضاضة والسذاجة، لأن العروبية ومنازعها لم تفارقهم حينئذ ولم يتحول عنهم شعار البداوة إلى شعار الحضارة. وأما بالأندلس فتلقبوا كسلفهم مع ما علموه من أنفسهم من القصور عن ذلك بالقصور عن ملك الحجاز أصل العرب والملة، والبعد عن دار الخلافة التي هي مركز العصبية، وأنهم إنما منعوا بإمارة القاصية أنفسهم من مهالك بني العباس. حتى إذا جاء عبد الرحمن الداخل الآخر منهم وهو الناصر بن محمد ابن الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط لأول المائة الرابعة، واشتهر ما نال الخلافة بالمشرق من الحجر واستبداد الموالي وعيثهم في الخلفاء بالعزل والاستبدال والقتل والسمل، ذهب عبد الرحمن هذا إلى مثل مذاهب الخلفاء بالمشرق وإفريقية، وتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالناصر لدين الله، وأخذت من بعده عادة ومذهباً لقن عنه، ولم يكن لآبائه وسلف قومه.
واستمر الحال على ذلك إلى أن انقرضت عصبية العرب أجمع وذهب رسم الخلافة وتغلب الموالي من العجم على بني العباس، والصنائع على العبيديين بالقاهرة، وصنهاجة على أمراء إفريقية، وزناتة على المغرب، وملوك الطوائف بالأندلس على أمر بني أمية، واقتسموة، وافترق أمر الإسلام، فاختلفت مذاهب الملوك بالمغرب والمشرق في الاختصاص بالألقاب بعد أن تسموا جميعاً باسم السلطان.
فأما ملوك المشرق من العجم فكان الخلفاء يخصونهم بألقاب تشريفية حتى يستشعر منها انقيادهم وطاعتهم وحسن ولايتهم، مثل شرف الدولة وعضد الدولة وركن الدولة ومعز الدولة ونصير الدولة ونظام الملك وبهاء الدولة وذخيرة الملك وأمثال هذه. وكان العبيديون أيضاً يخصون بها أمراء صنهاجة. فلما استبدوا على الخلافة قنعوا بهذه الألقاب وتجافوا عن ألقاب الخلافة أدباً معها، وعدولاً عن سمتها المختصة بها، شأن المتغلبين المستبدين كما قلناه قبل.
ونزع المتأخرون أعاجم المشرق، حين قوي استبدادهم على الملك، وعلا كعبهم في الدولة والسلطان، وتلاشت عصبية الخلافة واضمحلت بالجملة، إلى انتحال الألقاب الخاصة بالملك، مثل الناصر والمنصور زيادة على ألقاب يختصون بها قبل هذا الانتحال مشعرة بالخروج عن ربقة الولاء والاصطناع بما أضافوها إلى الدين فقط، فيقولون: صلاح الدين، أسد الدين، نور الدين.
وأما ملوك الطوائف بالأندلس فاقتسموا ألقاب الخلافة وتوزعوها لقوة استبدادهم عليها بما كانوا من قبيلها وعصبيتها، فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والمظفر وأمثالها، كما قال ابن أبي شرف ينعى عليهم:
مما يزهدني في أرض أندلس ... أسماء معتمد فيها ومعتضد
ألقاب مملكة في غير موضعها ... كالهر يحكي انتفاخاً صورة الأسد
وأما صنهاجة فاقتصروا على الألقاب التي كان الخلفاء العبيديون يلقبون بها للتنويه: مثل نصير الدولة، ومعز الدولة. واتصل لهم ذلك لما أدالوا من دعوة العبيديين بدعوة العباسيين. ثم بعدت الشقة بينهم وبين الخلافة ونسوا عهدها، فنسوا هذه الألقاب واقتصروا على اسم السلطان. وكذا شأن ملوك مغراوة بالمغرب لم ينتحلوا شيئاً من هذه الألقاب إلا اسم السلطان جرياً على مذاهب البداوة والغضاضة.
ولما محي رسم الخلافة وتعطل دستها، وقام بالمغرب من قبائل البربر يوسف بن تاشفين ملك لمتونة فملك العدوتين، وكان من أهل الخير والاقتداء، نزعت به همته إلى الدخول في طاعة الخليفة تكميلاً لمراسم دينه. فخاطب المستظهر العباسي وأوفد عليه ببيعته عبد الله بن العربي وابنه القاضي أبا بكر من مشيخة إشبيلية يطلبان توليته إياه على مغرب وتقليده ذلك، فانقلبوا إليه بعهد الخلافة له على المغرب واستشعار زيهم في لبوسه ورتبته، وخاطبه فيه بأمير المؤمنين تشريفاً له واختصاصاً فاتخذها لقباً. ويقال: إنه كان دعي له بأمير المؤمنين من قبل، أدباً مع رتبة الخلافة، لما كان عليه. هو وقومه المرابطون من انتحال الدين واتباع السنة.
وجاء المهدي على أثرهم داعياً إلى الحق آخذاً بمذاهب الأشعرية ناعياً على أهل المغرب عدولهم عنها إلى تقليد السلف في ترك التأويل لظواهر الشريعة، وما يؤول إليه ذلك من التجسيم، كما هو معروف من مذهب الأشعرية. وسمى أتباعه الموحدين تعريضاً بذلك النكير. وكان يرى رأي أهل البيت في الإمام المعصوم وأنه لا بد منه في كل زمان يحفظ بوجوده نظام هذا العالم، فسمي بالإمام لما قلناه أولاً من مذهب الشيعة في ألقاب خلفائهم، وأردف بالمعصوم إشاعة إلى مذهبه في عصمة الإمام. وتنزه عند أتباعه عن أمير المؤمنين أخذاً بمذاهب المتقدمين من الشيعة، ولما فيها من مشاركة الأغمار والولدان من أعقاب أهل الخلافة يومئذ بالمشرق. ثم انتحل عبد المؤمن ولي عهده اللقب بأمير المؤمنين، وجرى عليه من بعده خلفاء بني عبد المؤمن وآل أبي حفص من بعدهم، استئثاراً به عمن سواهم، لما دعا إليه شيخهم المهدي من ذلك، وأنه صاحب الأمم وأولياؤه من بعده كذلك دون كل أحد، لانتفاء عصبية قريش وتلاشيها. فكان ذلك دأبهم.
ولما انتقض الأمر بالمغرب وانتزعه زناتة ذهب أولهم مذاهب البداوة والسذاجة واتباع لمتونة في انتحال اللقب بأمير المؤمنين أدباً مع رتبة الخلافة التي كانوا على طاعتها لبني عبد المؤمن أولاً ولبني أبي حفص من بعدهم. ثم نزع المتأخرون منهم إلى اللقب بأمير المؤمنين وانتحلوه لهذا العهد استبلاغاً في منازع الملك وتتميماً لمذاهبه وسماته. والله غالب على أمره.
الفصل الثالث والثلاثون
في شرح اسم البابا والبطرك
في الملة النصرانية واسم الكوهن عند اليهود اعلم أن الملة لا بد لها من قائم عند غيبة النبي يحملهم على أحكامها وشرائعها، ويكون كالخليفة فيهم للنبي فيما جاء به من التكاليف. والنوع الأنساني أيضاً، بما تقدم من ضرورة السياسة فيهم للاجتماع البشري، لا بد لهم من شخص يحملهم على مصالحهم ويزعهم عن مفاسدهم بالقهر، وهو المسمى بالملك.والملة الإسلامية لما كان الجهاد فيها مشروعاً لعموم الدعوة وحمل الكافة على دين الإسلام طوعاً أو كرهاً اتخذت فيها الخلافة والملك لتوجه الشوكة من القائمين بها إليهما معاً.
وأما ما سوى الملة الإسلامية فلم تكن دعوتهم عامة ولا الجهاد عندهم مشروعاً إلا في المدافعة فقط، فصار القائم بأمر الدين فيها لا يعنيه شيء من سياسة الملك، وإنما وقع الملك لمن وقع منهم بالعرض ولأمر غير ديني، وهو ما اقتضتة لهم العصبية لما فيها من الطلب للملك بالطبع لما قدمناه، لأنهم غير مكلفين بالتغلب على الأمم كما في الملة الإسلامية، وإنما هم مطلوبون بإقامة دينهم في خاصتهم.
ولذلك بقي بنو إسرائيل من بعد موسى ويوشع صلوات الله عليهما نحو أربعمائة سنة لا يعتنون بشيء من أمر الملك، إنما همهم إقامة دينهم فقط. وكان القائم به بينهم يسمى الكوهن كأنه خليفة موسى صلوات الله عليه يقيم لهم أمر الصلاة والقربان، ويشترطون فيه أن يكون من ذرية هارون صلوات الله عليه، لأن موسى لم يعقب. ثم اختاروا لإقامة السياسة التي هي للبشر بالطبع سبعين شيخاً كانوا يتولون أحكامهم العامة. والكوهن أعظم منهم رتبة في الدين، وأبعد عن شغب الأحكام. واتصل ذلك فيهم إلى أن استحكمت طبيعة العصبية وتمحضت الشوكة للملك، فغلبوا الكنعانيين على الأرض التي أورثهم الله - بيت المقدس وما جاورها - كما بين لهم على لسان موسى صلوات الله عليه، فحاربتهم أمم الفلسطين والكنعانيين والأرمن وأردن وعمان ومأرب، ورئاستهم في ذلك راجعة إلى شيوخهم، وأقاموا على ذلك نحواً من أربعمائة سنة، ولم تكن لهم صولة الملك. وضجر بنو إسرائيل من مطالبة الأمم، فطلبوا على لسان شمويل من أنبيائهم أن يأذن الله لهم في تمليك رجل عليهم فولي عليهم طالوت، وغلب الأمم وقتل جالوت ملك الفلسطين. ثم ملك بعده داود ثم سليمان صلوات الله عليهما. واستفحل ملكه وامتد إلى الحجاز، ثم أطراف اليمن، ثم إلى أطراف بلاد الروم. ثم افترق الأسباط من بعد سليمان صلوات الله عليه بمقتضى العصبية في الدول كما قدمناه، إلى دولتين كانت إحداهما بالجزيرة والموصل للأسباط العشرة، والأخرى بالقدس والشام لبني يهوذا وبنيامين.
ثم غلبهم بختنصر ملك بابل على ما كان بأيديهم من الملك، أولاً الأسباط العشرة، ثم ثانياً بني يهوذا وبيت المقدس بعد اتصال ملكهم نحو ألف سنة، وخرب مسجدهم وأحرق توراتهم وأمات دينهم، ونقلهم إلى أصبهان وبلاد العراق، إلى أن ردهم بعض ملوك الكيانية من الفرس إلى بيت المقدس من بعد سبعين سنة من خروجهم، فبنوا المسجد وأقاموا أمر دينهم على الرسم الأول للكهنة فقط والملك للفرس. ثم غلب الإسكندر وبنو يونان على الفرس وصار اليهود في ملكتهم. ثم فشل أمر اليونانيين، فاعتز اليهود عليهم بالعصبية الطبيعية ودفعوهم عن الاستيلاء عليهم، وقام بملكهم الكهنة الذين كانوا فيهم من بني حشمناي، وقاتلوا اليونان حتى انقرض أمرهم، وغلبهم الروم فصاروا تحت أمرهم. ثم رجعوا إلى بيت المقدس وفيها بنو هيرودس اصهار بني حشمناي، وبقيت دولتهم، فحاصروهم مدة، ثم افتتحوها عنوة، وأفحشوا في القتل والهدم والتحريق، وخربوا بيت المقدس وأجلوهم عنها إلى رومة وما وراءها، وهو الخراب الثاني للمسجد، ويسميه اليهود بالجلوة الكبرى. فلم يقم لهم بعدها ملك لفقدان العصبية منهم وبقوا بعد ذلك في ملكة الروم ومن بعدهم، يقيم لهم أمر دينهم الرئيس عليهم المسمى بالكوهن.
ثم جاء المسيح صلوات الله وسلامه عليه بما جاءهم به من الدين والنسخ لبعض أحكام التوراة، وظهرت على يديه الخوارق العجيبة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، واجتمع عليه كثير من الناس وآمنوا به، وأكثرهم الحواريون من أصحابه وكانوا اثني عشر، وبعث منهم رسلاً إلى الأفاق داعين إلى ملته، وذلك أيام أوغسطس أول ملوك القياصرة، وفي مدة هيرودس، ملك اليهود، الذي انتزع الملك من بني حشمناي أصهاره. فحسده اليهود وكذبوه، وكاتب هيرودس ملكهم ملك القياصرة أوغسطس يغريه به، فأذن لهم في قتله ووقع ما تلاه القرآن من أمره. وافترق الحواريون شيعاً ودخل أكثرهم بلاد الروم داعين إلى دين النصرانية. وكان بطرس كبيرهم فنزل برومة، دار ملك القياصرة ثم كتبوا الإنجيل الذي أنزل على عيسى صلوات الله عليه، في نسخ أربع على اختلاف رواياتهم: فكتب متى إنجيله في بيت المقدس بالعبرانية، ونقله يوحنا بن زيدى منهم إلى اللسان اللاطيني، وكتب لوقا منهم إنجيله باللطيني إلى بعض أكابر الروم، وكتب يوحنا بن زبدى منهم إنجيله برومة، وكتب بطرس إنجيله باللطيني ونسبه إلى مرقاص تلميذه. واختلفت هذه النسخ الأربع من الأنجيل، مع أنها ليست كلها وحياً صرفاً بل مشوبة بكلام عيسى عليه السلام، وبكلام الحواريين، وكلها مواعظ وقصص، والأحكام فيها قليلة جداً. واجتمع الحواريون الرسل لذلك العهد برومة، ووضعوا قوانين الملة النصرانية، وصيروها بيد أقليمنطس تلميذ بطرس، وكتبوا فيها عدد الكتب التي يجب قبولها والعمل بها.
فمن شريعة اليهود القديمة التوراة، وهي خمسة أسفار، وكتاب يوشع، وكتاب القضاة، وكتاب راعوث، وكتاب يهوذا، وأسفار الملوك أربعة، وسفر بنيامين، وكتب المقابيين لابن كريون ثلاثة وكتاب عزرا الإمام، وكتاب أوشير وقصة هامان، وكتاب أيوب الصديق، ومزامير داود عليه السلام، وكتب ابنه سليمان عليه السلام خمسة، ونبوات الأنبياء الكبار والصغار ستة عشر، وكتاب يشوع بن شارخ وزير سليمان.
ومن شريعة عيسى صلوات الله عليه المتلقاة من الحواريين نسخ الإنجيل الأربعة وكتب القتاليقون سبع رسائل، وثامنها الأبريكسيس في قصص الرسل وكتاب بولس أربع عشرة رسالة، وكتاب أقليمنطس وفيه الأحكام، وكتاب أبو غالمسيس، وفيه رؤيا يوحنا بن زبدى.
واختلف شأن القياصرة في الأخذ بهذه الشريعة تارة وتعظيم أهلها، ثم تركها أخرى والتسلط عليهم بالقتل والبغي، إلى أن جاء قسطنطين وأخذ بها واستمروا عليها. وكان صاحب هذا الدين والمقيم لمراسمه يسمونه البطرك، وهو رئيس الملة عندهم وخليفة المسيح فيهم، يبعث نوابه وخلفاءه إلى ما بعد عنه من أمم النصرانية، ويسمون الأسقف أي نائب البطرك، ويسمون الإمام الذي يقيم الصلوات ويفتيهم في الدين بالقسيس. ويمفون المنقطع الذي حبس نفسه في الخلوة للعبادة بالراهب. وأكثر خلواتهم في الصوامع. وكان بطرس الرسول رأس الحواريين وكبير التلاميذ برومة يقيم بها دين النصرانية إلى أن قتله نيرون خامس القياصرة، فيمن قتل من البطارق والأساقفة، ثم قام بخلافته في كرسي رومة أريوس. وكان مرقاس الإنجيلي بالإسكندرية ومصر والمغرب داعياً سبع سنين، فقام بعده حنانيا وتسمى بالبطرك وهو أول البطاركة فيها. وجعل معه اثني عشر قساً على أنه إذا مات البطرك يكون واحد من الاثني عشر مكانة ويختار من المؤمنين واحداً مكان ذلك الثاني عشر. فكان أمر البطاركة إلى القسوس. ثم لما وقع الاختلاف بينهم في قواعد دينهم وعقائده واجتمعوا بنيقية ايام قسطنطين لتحرير الحق في الدين، واتفق ثلثمائة وثمانية عشر من أساقفتهم على رأي واحد في الدين، فكتبوه وسموه الإمام، وصيروه أصلاً يرجعون إليه. وكان فيما كتبوه أن البطرك القائم بالدين لا يرجع في تعيينه إلى اجتهاد الأقسة كما قرره حنانيا تلميذ مرقاس، وأبطلوا ذلك الرأي، وإنما يقدم عن ملإ واختيار من أئمة المؤمنين ورؤسائهم، فبقي الأمر كذلك، ثم اختلفوا بعد ذلك في تقرير قواعد الدين وكانت لهم مجتمعات في تقريره. ولم يختلفوا في هذه القاعدة، فبقي الأمر فيها على ذلك. واتصل فيهم نيابة الأساقفة عن البطاركة. وكان الأساقفة يدعون البطرك بالأب أيضاً تعظيماً له. فاشتبه الاسم في أعصار متطاولة، يقال آخرها بطركية هرقل بالإسكندرية، فأرادوا أن يميزوا البطرك عن الأسقف في التعظيم فدعوه البابا، ومعناه أبو الأباء. وظهر هذا الأسم أول ظهوره بمصر على ما زعم جرجيس بن العميد في تاريخه. ثم نقلوه إلى صاحب الكرسي الأعظم عندهم وهو كرسي رومة لأنه كرسي بطرس الرسول كما قدمناه، فلم يزل سمة عليه إلى الأن.
ثم اختلفت النصارى في دينهم بعد ذلك، وفيما يعتقدونه في المسيح، وصاروا طوائف وفرقاً، واستظهروا بملوك النصرانية كل على صاحبه، فاختلف الحال في العصور في ظهور فرقة دون فرقة، إلى أن استقرت لهم ثلاث طوائف هي فرقهم ولا يلتفون إلى غيرها، وهم الملكية واليعقوبية والنسطورية.
ثم اختصت كل فرقة منهم ببطرك، فبطرك رومة اليوم المسمى بالبابا على رأي الملكية، ورومة للإفرنجة وملكهم قائم بتلك الناحية. وبطرك المعاهدين بمصر على رأي اليعقوبية وهو ساكن بين ظهرانيهم، والحبشة يدينون بدينهم، ولبطرك مصر فيهم أساقفة ينوبون عنه في إقامة دينهم هنالك. واختص اسم البابا ببطرك رومة لهذا العهد. ولا تسمي اليعاقبة بطركهم بهذا الاسم. وضبط هذه اللفظة بباءين موحدتين من أسفل، والنطق بها مفخمة والثانية مشددة. ومن مذاهب البابا عند الإفرنجة أنه يحضهم على الانقياد لملك واحد يرجعون إليه في اختلافهم واجتماعهم تحرجاً من افتراق الكلمة، ويتحرى به العصبية التي لا فوقها منهم، لتكون يده عالية على جميعهم، ويسمونه الأنبرذور وحرفه الوسط بين الذال والظاء المعجمتين، ومباشرة يضع التاج على رأسه للتبرك فيسمى المتوج، ولعله معنى لفظة الإنبرذور. وهذا ملخص ما أوردناه من شرح هذين الاسمين اللذين هما البابا والكوهن، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء.
الفصل الرابع والثلاثون
في مراتب الملك والسلطان وألقابها
اعلم أن السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمراً ثقيلاً، فلا بد له من الاستعانة بأبناء جنسه. وإذا كان يستعين بهم في ضرورة معاشه وسائر مهنه فما ظنك بسياسة نوعه ومن استرعاه الله من خلقه وعباده. وهو محتاج إلى حماية الكافة من عموهم بالمدافعة عنهم، وإلى كف عدوان بعضهم على بعض في أنفسهم بإمضاء الأحكام الوازعة فيهم، وكف العدوان عليهم في أموالهم بإصلاح سابلتهم، وإلى حملهم على مصالحهم، وما تعمهم به البلوى في معاشهم ومعاملاتهم من تفقد المعايش والمكاييل والموازين، حذراً من التطفيف، وإلى النظر في السكة بحفظ النقود التي يتعاملون بها من الغش، وإلى سياستهم بما يريده منهم من الانقياد له والرضا بمقاصده منهم وانفراده بالمجد دونهم. فيتحمل من ذلك فوق الغاية من معاناة القلوب. قال بعض الأشراف من الحكماء: " لمعاناة نقل الجبال من أماكنها أهون علي من معاناة قلوب الرجال " .
ثم أن الاستعانة إذا كانت بأولي القربى من أهل النسب أو التربية أو الاصطناع القديم للدولة كانت أكمل، لما يقع في ذلك من مجانسة خلقهم لخلقه، فتتم المشاكلة في الاستعانة. قال تعالى: " واجعل لي وزيراً من أهلي، هارون أخي، أشدد به أزري، وأشركه في أمري " .
وهو إما أن يستعين في ذلك بسيفه أو قلمه أو رأيه أو معارفه أو بحجابه عن الناس أن يزدحموا عليه، فيشغلوه عن النظر في مهماتهم. أو يدفع النظر في الملك كله، ويعول على كفايته في ذلك واضطلاعه. فلذلك قد توجد في رجل واحد وقد تفترق في أشخاص. وقد يتفرع كل واحد منها إلى فروع كثيرة: كالقلم يتفرع إلى قلم الرسائل والمخاطبات، وقلم الصكوك والإقطاعات، وإلى قلم المحاسبات، وهو صاحب الجباية والعطاء وديوان الجيش وكالسيف يتفرع إلى صاحب الحرب، وصاحب الشرطة، وصاحب البريد، وولاية الثغور.
ثم اعلم أن الوظائف السلطانية في هذه الملة الإسلامية مندرجة تحت الخلافة لاشتمال منصب الخلافة على الدين والدنيا كما قدمناه. فالأحكام الشرعية متعلقة بجميعها وموجودة لكل واحدة منها في سائر وجوهها، لعموم تعلق الحكم الشرعي بجميع أفعال العباد. والفقيه ينظر في مرتبة الملك والسلطان وشروط تقليدها استبداداً على الخلافة وهو معنى السلطان، أو تعويضاً منها وهو معنى الوزارة عندهم كما يأتي، وفي نظره في الأحكام والأموال وسائر السياسات مطلقاً أو مقيداً، أو في موجبات العزل أن عرضت، وغير ذلك من معاني الملك والسلطان وكذا في سائر الوظائف التي تحت الملك والسلطان من وزارة أو جباية أو ولاية. لا بد للفقيه من النظر في جميع ذلك لما قدمناه من انسحاب حكم الخلافة الشرعية في الملة الإسلامية على رتبة الملك والسلطان. إلا أن كلامنا في وظائف الملك والسلطان ورتبته، إنما هو بمقتضى طييعة العمران ووجود البشر لا بما يخصها من أحكام الشرع فليس من غرض كتابنا كما علمت، فلا نحتاج إلى تفصيل أحكامها الشرعية، مع أنها مستوفاة في كتب الأحكام السلطانية مثل كتاب القاضي أبي الحسن الماوردي وغيره من أعلام الققهاء، فإن أردت استيفاءها فعليك بمطالعتها هنالك. وإنما تكلمنا في الوظائف الخلافية وأفردناها لنميز بينها وبين الوظائف السلطانية فقط، لا لتحقيق أحكامها الشرعية، فليس من غرض كتابنا، وإنما نتكلم في ذلك بما تقتضيه طبيعة العمران في الوجود الأنساني. والله الموفق.
الوزارة
وهي أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية، لأن اسمها يدل على مطلق الإعانة، فإن الوزارة مأخوذة إما من المؤازرة وهي المعاونة، أو من الوزر وهو الثقل كأنه يحمل مع مفاعله أوزاره، وأثقاله، وهو راجع إلى المعاونة المطلقة. وقد كنا قدمنا في أول الفصل أن أحوال السلطان وتصرفاته لا تعدو أربعة: لأنها إما أن تكون في أمور حماية الكافة وأسبابها من النظر في الجند والسلاح والحروب وسائر أمور الحماية والمطالبة، وصاحب هذا هو الوزير المتعارف قي الدول القديمة بالمشرق، ولهذا العهد بالمغرب، وإما أن تكون في أمور مخاطباته لمن بعد عنه في المكان أو في الزمان وتنفيذه، الأوامر فيمن هو محجوب عنه وصاحب هذا هو الكاتب، وإما أن تكون في أمور جباية المال وإنفاقه، وضبط ذلك من جميع وجوهه أن يكون بمضيعة، وصاحب هذا هو صاحب المال والجباية وهو المسمى بالوزير لهذا العهد بالمشرق، وإما أن يكون في مدافعة الناس ذوي الحاجات عنه أن يزدحموا عليه فيشغلوه عن فهمه، وهذا راجع لصاحب الباب الذي يحجبه. فلا تعدو أحواله هذه الأربعة بوجه. وكل خطة أو رتبة من رتب الملك والسلطان فإليها ترجع. إلا أن الأرفع منها ما كانت الإعانة فيه عامة فيما تحت يد السلطان من ذلك الصنف، إذ هو يقتضي مباشرة السلطان دائماً ومشاركته فى كل صنف من أحوال ملكه. وأما ما كان خاصاً ببعض الناس أو ببعض الجهات فيكون دون الرتبة الأخرى كقيادة ثغر أو ولاية جباية خاصة أو النظر في أمر خاص، كحسبة الطعام أو النظر في السكة، فإن هذه كلها نظر في أحوال خاصة، فيكون صاحبها تبعاً لأهل النظر العام، وتكون رتبته مرؤوسة لأولئك.
وما زال الأمر في الدول قبل الإسلام هكذا حتى جاء الإسلام وصار الأمر خلافة، فذهبت تلك الخطط كلها بذهاب رسم الملك إلا ما هو طبيعي من المعاونة بالرأي، والمفاوضة فيه فلم يمكن زواله، إذ هو أمر لا بد منه. فكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه ويفاوضهم في مهماته العامة والخاصة، ويخص مع ذلك أبا بكر بخصوصيات أخرى، حتى كان العرب الذين عرفوا الدول وأحوالها في كسرى وقيصر والنجاشي يسمون أبا بكر وزيره. ولم يكن لفظ الوزير يعرف بين المسلمين لذهاب رتبة الملك بسذاجة الإسلام. وكذا عمر مع أبي بكر، وعلي وعثمان مع عمر. وأما حال الجباية والإنفاق والحسبان فلم يكن عندهم برتبة، لأن القوم كانوا عرباً أميين لا يحسنون الكتاب والحساب فكانوا يستعملون في الحساب أهل الكتاب أو أفراداً من موالي العجم ممن يجيده، وكان قليلاً فيهم. وأما أشرافهم فلم يكونوا يجيدونه، لأن الأمية كانت صفتهم التي امتازوا بها. وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الأمور لم تكن عندهم رتبة خاصة للأمية التي كانت فيهم، والأمانة العامة في كتمان القول وتأديته، ولم تخرج السياسة إلى اختياره، لأن الخلافة إنما هي دين ليست من السياسة الملكية في شيء. وأيضاً فلم تكن الكتابة صناعة فيستجاد للخليفة أحسنها، لأن الكل كانوا يعبرون عن مقاصدهم بأبلغ العبارات. ولم يبق إلا الخط فكان الخليفة يستنيب في كتابته، متى عن له، من يحسنه. وأما مدافعة ذوي الحاجات عن أبوابهم، فكان محظوراً بالشريعة فلم يفعلوه.
فلما انقلبت الخلافة إلى الملك وجاءت رسوم السلطان وألقابه كان أول شيء بدىء به في الدولة شأن الباب وسده دون الجمهور بما كانوا يخشون على أنفسهم من اغتيال الخوارج وغيرهم كما وقع بعمر وعلي ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم، مع ما في فتحه من ازدحام الناس عليهم وشغلهم بهم عن المهمات. فاتخذوا من يقوم لهم بذلك وسموه الحاجب. وقد جاء أن عبد الملك لما ولى حاجبه قال له: قد وليتك حجابة بابي إلا عن ثلاثة: المؤذن للصلاة فإنه داعي الله، وصاحب البريد فأمر ما جاء به، وصاحب الطعام لئلا يفسد. ثم استفحل الملك بعد ذلك فظهر المشاور والمعين في أمور القبائل والعصائب واستئلافهم، وأطلق عليه اسم الوزير. وبقي أمر الحسبان في الموالي والذميين. واتخذ للسجلات كاتب مخصوص حوطة على أسرار السلطان أن تشتهر فتفسد سياسته مع قومه، ولم يكن بمثابة الوزير لأنه إنما احتيج له من حيث الخط . والكتاب لا من حيث اللسان الذي هو الكلام، إذ اللسان لذلك العهد على حاله لم يفسد. فكانت الوزارة لذلك أرفع رتبهم يومئذ. هذا في سائر دولة بني أمية. فكان النظر للوزير عاماً في أحوال التدبير والمفاوضات وسائر أمور الحمايات والمطالبات وما يتبعها من النظير في ديوان الجند وفرض العطاء بالأهلية وغير ذلك.
فلما جاءت دولة بني العباس واستفحل الملك وعظمت مراتبه وارتفعت، عظم شأن الوزير وصارت إليه النيابة في إنفاذ الحل والعقد وتعينت مرتبته في الدولة، وعنت لها الوجوه وخضعت لها الرقاب، وجعل لها النظر في ديوان الحسبان لما تحتاج إليه خطته من قسم الأعطيات في الجند، فاحتاج إلى النظر في جمعه وتفريقه، وأضيف إليه النظر فيه. ثم جعل له النظر في القلم والترسيل لصون أسرار السلطان ولحفظ البلاغة، لما كان اللسان قد فسد عند الجمهور. وجعل الخاتم لسجلات السلطان ليحفظها من الذياع والشياع ودفع إليه. فصار اسم الوزير جامعاً لخطتي السيف والقلم، وسائر معاني الوزارة والمعاونة، حتى لقد دعي جعفر بن يحيى بالسلطان أيام الرشيد إشارة إلى عموم نظره وقيامه بالدولة. ولم يخرج عنه من الرتب السلطانية كلها إلا الحجابة التي هي القيام على الباب فلم تكن له، لاستنكافه عن مثل ذلك.
ثم جاء في الدولة العباسية شأن الاستبداد على السلطان، وتعاور فيها استبداد الوزارة مرة والسلطان آخرى. وصار الوزير إذا استبد محتاجاً إلى استنابة الخليفة إياه لذلك لتصح الأحكام الشرعية وتجيء على حالها كما تقدم. فانقسمت الوزارة حينئذ إلى وزارة تنفيذ، وهي حال ما يكون السلطان قائماً على نفسه، وإلى وزارة تفويض وهي حال ما يكون الوزير مستبداً عليه. ثم استمر الاستبداد وصار الأمر لملوك العجم وتعطل رسم الخلافة. ولم يكن لأولئك المتغلبين أن ينتحلوا ألقاب الخلافة، واستنكفوا من مشاركة الوزراء في اللقب لأنهم خول لهم، فتسموا بالإمارة والسلطان. وكان المستبد على الدولة يسمى أمير الأمراء أو بالسلطان، إلى ما يحليه به الخليفة من ألقابه كما تراة في ألقابهم، وتركوا اسم الوزارة إلى من يتولاها للخليفة في خاصته. ولم يزل هذا الشأن عندهم إلى آخر دولتهم. وفسد اللسان خلال ذلك كله، وصارت صناعة ينتحلها بعض الناس، فامتهنت وترفع الوزراء عنها لذلك، ولأنهم عجم، وليست تلك البلاغة هي المقصودة من لسانهم فتخير لها من سائر الطبقات واختصت به، وصارت خادمة للوزير. واختص اسم الأمير بصاحب الحروب والجند وما يرجع إليها، ويده مع ذلك عالية على أهل الرتب، وأمره نافذ في الكل إما نيابة أو استبدادا. واستمر الأمر على هذا.
ثم جاءت دولة الترك آخراً بمصر فرأوا أن الوزارة قد ابتذلت بترفع أولئك عنها ودفعها لمن يقوم بها للخليفة المحجور، ونظره مع ذلك متعتقب بنظر الأمير، فصارت مرؤوسة ناقصة، فاستنكف أهل هذه الرتبة المالية في الدولة عن اسم الوزارة. وصار صاحب الأحكام والنظر في الجند يسمى عندهم بالنائب لهذا العهد، وبقي اسم الحاجب في مدلوله، واختص اسم الوزير عندهم بالنظر في الجباية.
وأما دولة بني أمية بالأندلس فأنفوا اسم الوزير في مدلوله أول الدولة، ثم قسموا خطته أصنافاً وأفردوا لكل صنف وزيراً: فجعلوا لحسبان المال وزيراً، وللترسيل وزيراً، وللنظر في حوائج المتظلمين وزيراً، وللنظر في أحوال أهل الثغور وزيراً وجعل لهم بيت يجلسون فيه على فرش منضمة لهم، وينفذون أمر السلطان هناك كل فيما جعل له. وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد منهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطان في كل وقت، فارتفع مجلسه عن مجالسهم وخصوه باسم الحاجب، ولم يزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم، فارتفعت خطة الحاجب ومرتبته على سائر الرتب، حتى صار ملوك الطوائف ينتحلون لقبها فأكثرهم يومئذ يسمى الحاجب كما نذكره.
ثم جاءت دولة الشيعة بإفريقية والقيروان وكان للقائمين بها رسوخ في البداوة فأغفلوا أمر هذه الخطط أولاً وتنقيح أسمائها حتى أدركت دولتهم الحضارة فصاروا إلى تقليد الدولتين قبلهم في وضع أسمائها كما تراه في أخبار دولتهم.
ولما جاءت دولة الموحدين من بعد ذاك أغفلت الأمر أولاً للبداوة، ثم صارت إلى انتحال الأسماء والألقاب. وكان اسم الوزير في مدلوله. ثم اتبعوا دولة الأمويين وقلدوها في مذاهب السلطان واختاروا اسم الوزير لمن يحجب السلطان في مجلسه، ويقف بالوفود والداخلين على السلطان عند الحدود في تحيتهم وخطابهم والآداب التي تلزم في الكون بين يديه، ورفعوا خطة الحجابة عنه ما شاؤوا ولم يزل الشأن ذلك إلى هذا العهد.
وأما في دولة الترك بالمشرق فيسمون هذا الذي يقف بالناس على حدود الأداب في اللقاء والتحية في مجالس السلطان والتقدم بالوفود بين يديه الدويدار، ويضيفون إليه استتباع كاتب السر وأصحاب البريد المتصرفين في حاجات السلطان بالقاصية وبالحاضرة. وحالهم على ذلك لهذا العهد. والله مولي الأمور لمن يشاء.
الحجابةقخد قدمنا أن هذا اللقب كان مخصوصاً في الدولة الأمويه والعباسية بمن يحجب السلطان عن العامة ويغلق بابه دونهم أو يفتحه لهم على قدره في مواقيته. وكانت هذه منزلة يومئذ عن الخطط مرؤوسة لها، إذ الوزير متصرف فيها بما يراه. وهكذا كانت، سائر أيام بني العباس، وإلى هذا العهد، فهي بمصر مرؤوسة لصاحب الخطة العليا المسمى بالنائب.
وأما في الدولة الأموية بالأندلس فكانت الحجابة لمن يحجب السلطان في الخاصة والعامة، ويكون واسطة بينه وبين الوزراء، فمن دونهم. فكانت في دولتهم رفيعة غاية كما تراه في أخبارهم، كابن حديد وغيره من حجابهم. ثم لما جاء الاستبداذ على الدولة اختص المستبد باسم الحجابة لشرفها. فكان المنصور بن أبي عامر وأبناؤه كذلك. ولما بدؤوا في مظاهر الملك وأطواره جاء من بعدهم من ملوك الطوائف فلم يتركوا لقبها، وكانوا يعدونها شرفاً لهم، وكان أعظمهم ملكاً بعد انتحال ألقاب الملك وأسمائه لا بد له من ذكر الحاجب وفي الوزارتين يعنون به السيف والقلم، ويدلون بالحجابة على حجابة السلطان عن العامة والخاصة، وبذي الوزارتين على جمعه لخطتي السيف والقلم.
ثم لم يكن في دول المغرب وإفريقية ذكر لهذا الاسم للبداوة التي كانت فيهم.
وربما يوجد في دولة العبيديين بمصر عند استعظامها وحضارتها إلا أنه قليل.
ولما جاءت دولة الموحدين لم تستمكن فيها الحضارة الداعية إلى انتحال الألقاب وتمييز الخطط وتعيينها بالأسماء إلا آخراً. فلم يكن عندهم من الرتب إلا الوزير، فكانوا أولاً يخصون بهذا الاسم الكاتب المتصرف المشارك للسلطان في خاص أمره، كابن عطية وعبد السلام الكومي. وكان له مع ذلك النظر في الحساب والأشغال المالية. ثم صار بعد ذلك اسم الوزير لأهل نسب الدولة من الموحدين كابن جامع وغيره. ولم يكن اسم الحاجب معروفاً في دولتهم يومئذ.
وأما بنو أبي حفص بإفريقية فكانت الرياسة في دولتهم أولاً والتقديم لوزير الرأي والمشورة. وكان يخص باسم شيخ الموحدين. وكان له النظر في الولايات والعزل وقود العساكر والحروب، واختص الحسبان والديوان برتبة أخرى، ويسمى متوليها بصاحب الأشغال، ينظر فيها النظر المطلق في الدخل والخرج، ويحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب على التفريط، وكان من شرطه أن يكون من الموحدين. واختص عندهم القلم أيضاً بمن يجيد الترسيل ويؤتمن على الأسرار، لأن الكتابة لم تكن من منتحل القوم ولا الترسيل بلسانهم، فلم يشترط فيه النسب واحتاج السلطان لاتساع ملكه وكثرة المرتزقين بداره إلى قهرمان خاص بداره في أحواله يجريها على قدرها وترتيبها، من رزق وعطاء وكسوة ونفقة في المطابخ والاصطبلات وغيرهما، وحصر الذخيرة وتنفيذ ما يحتاج إليه في ذلك على أهل الجباية، فخصوه باسم الحاجب. وربما أضافوا إليه كتابة العلامة على السجلات إذا اتفق أنه يحسن صناعة الكتابة، وربما جعلوه لغيره. واستمر الأمر على ذلك، وحجب السلطان نفسه عن الناس، فصار هذا الحاجب واسطة بين الناس وبين أهل الرتب كلهم. ثم جمع له آخر الدولة السيف والحرب، ثم الرأي والمشورة، فصارت الخطة أرفع الرتب وأوعبها للخطط. ثم جاء الاستبداد والحجر مدة من بعد السلطان الثاني عشر منهم. ثم استبد بعد ذلك حفيده السلطان أبو العباس على نفسه وأذهب آثار الحجر والاستبداد بإذهاب خطة الحجابة التي كانت سلماً إليه، وباشر أموره كلها بنفسه من غير استعانة بأحد. والأمر على ذلك لهذا العهد.
وأما دولة زناتة بالمغرب: وأعظمها دولة بني مرين، فلا آثر لاسم الحاجب عندهم. وأما رياسة الحرب والعساكر فهي للوزير. ورتبة القلم في الحسبان والرسائل راجعة إلى من يحسنها من أهلها، وإن اختصت ببعض البيوت المصطنعين في دولتهم. وقد تجمع عندهم وقد تفرق. وأما باب السلطان وحجبه عن العامة فهي رتبة عندهم، يسمى صاحبها بالمزوار ومعناه المقدم على الجنادرة المتصرفين بباب السلطان في تنفيذ أوامره وتصريف عقوباته وإنزال سطواته وحفظ المعتقلين في سجونه، والعريف عليهم في ذلك. فالباب له، وأخذ الناس بالوقوف عند الحدود في دار العامة راجع إليه، فكأنها وزارة صغرى.
وأما دولة بني عبد الواد: فلا أثر عندهم لشيء من هذه الألقاب ولا تمييز الخطط لبداوة دولتهم وقصورها. وإنما يخصون باسم الحاجب في بعض الأحوال منفذ الخاص بالسلطان في داره، كما كان في دولة بني أبي حفص، وقد يجمعون له الحسبان والسجل كما كان فيها، حملهم على ذلك تقليد الدولة بما كانوا في تبعها وقائمين بدعوتها منذ أول أمرهم.
وأما أهل الأندلس لهذا العهد فالمخصوص عندهم بالحسبان وتنفيذ. السلطان وسائر الأمور المالية يسمونه بالوكيل، وأما الوزير فكالوزير، إلا أنه قد يجمع الترسيل. والسلطان عندهم يضع خطه على السجلات كلها، فليس هناك خطة العلامة كما لغيرهم من الدول.
وأما دولة الترك بمصر: فاسم الحاجب عندهم موضوع لحاكم من أهل وهم الترك، ينفذ الأحكام بين الناس في المدينة، وهم متعددون. وهذه الوظيفة تحت وظيفة النيابة التي لها الحكم في أهل الدولة وفي العامة على الإطلاق. وللنائب التولية والعزل في بعض الوظائف على الأحيان، ويقطع القليل من الأرزاق، ويثبتها وتنفذ أوامره كما تنفذ المراسم السلطانية. وكان له النيابة المطلقة عن السلطان وللحجاب الحكم فقط في طبقات العامة والجند عند الترافع إليهم، وإجبار من أبى الانقياد للحكم، وطورهم تحت طور النيابة. والوزير في دولة الترك هو صاحب الأموال في الدولة على اختلاف أصنافها من خراج أومكس أوجزبة ثم في تصريفها في الإنفاقات السلطانية أو الجرايات المقدرة، وله مع ذلك التولية والعزل في سائر العمال المباشرين لهذه الجباية والتنفيذ عنى اختلاف مراتبهم وتباين أصنافهم ومن عوائدهم أن يكون هذا الوزير من صنف القبط القائمين على ديوان الحسبان، والجباية لاختصاصهم بذلك في مصر منذ عصور قديمة. وقد يوليها السلطان بعض الأحيان لأهل الشوكة من رجالات الترك أو أبنائهم على حسب الداعية لذلك. والله مدبر الأمور ومصرفها بحكمته، لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين.
ديوان الأعمال والجبايات
اعلم أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك، وهي القيام على الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج وإحصاء ا لعساكر بأسمائهم، وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم في إباناتها، والرجوع في ذلك إلى القوانين التي يرتبها قومه تلك الأعمال، وقهارمة الدولة، وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في الدخل والخرح مبني على جزء كبير من الحساب، لا يقوم به إلا المهرة من أهل تلك الأعمال، ويسمى ذلك الكتاب بالديوان، وكذلك مكان جلوس العمال المباشرين لها. ويقال: إن أصل هذه التسمية أن كسرى نظر يوماً إلى كتاب ديوانه وهم يحسبون على أنفسهم كأنهم يحادثون فقال: ديوانه أي مجانين بلغة الفرس، فسمي موضعهم بذلك، وحذفت الهاء لكثرة الاستعمال تخفيفاً ققيل ديوان، ثم نقل هذا الاسم إلى كتاب هذه الأعمال المتضمن للقوانين والحسبانات، وقيل: إنه اسم للشياطين بالفارسية، سمي الكتاب بذلك لسرعة نفوذهم في فهم الأمور ووقوفهم على الجلي والخفي منها، وجمعهم لما شذ وتفرق. ثم نقل إلى مكان جلوسهم لتلك الأعمال. وعلى هذا فيتناول اسم الديوان كتاب الرسائل ومكان جلوسهم بباب السلطان على ما يأتي بعد. وقد تفرد هذه الوظيفة بناظر واحد ينظر في سائر هذه الأعمال، وقد يفرد كل صنف منها بناظر، كما يفرد في بعض الدول النظر في العساكر وإقطاعاتهم وحسبان أعطياتهم، أو غير ذلك على حسب مصطلح الدولة وما قرره أولوها. واعلم أن هذه الوظيفة إنما تحدث في الدول عند تمكن الغلب والاستيلاء والنظر في أعطاف الملك وفنون التمهيد.
وأول من وضع الديوان في الدولة الإسلامية عمر رضي الله عنه يقال لسبب مال أتى به أبو هريرة رضي الله عنه من البحرين فاستكثروه وتعبوا في قسمه، فسموا إلى إحصاء الأموال وضبط العطاء والحقوق، فأشار خالد بن الوليد بالديوان، وقال: رأيت ملوك الشام يدونون، فقبل منه عمر. وقيل: بل أشار عليه به الهرمزان لما رآه يبعث البعوث بغير ديوان، فقيل له: ومن يعلم بغيبة من يغيب منهم؟ فإن من تخلف أخل بمكانه، وإنما يضبط ذلك الكتاب. فأثبت لهم ديواناً. وسأل عمر عن اسم الديوان، فعبر له. ولما اجتمع ذلك أمر عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم، وكانوا من كتاب قريش، فكتبوا ديوان العساكر الإسلامية على ترتيب الأنساب مبتدأ من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعدها، الأقرب فالأقرب. هكذا كان ابتداء ديوان الجيش. وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أن ذلك كان في المحرم سنة عشرين.
وأما ديوان الخراج والجبايات فبقي بعد الإسلام على ما كان عليه من قبل: ديوان العراق بالفارسية، وديوان الشام بالرومية. وكتاب الدواوين من أهل العهد من الفريقين. ولما جاء عبد الملك بن مروان واستحال الأمر ملكاً، وانتقل القوم من غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة، ومن سذاجة الأمية إلى حذق الكتابة، وظهر في العرب ومواليهم مهرة في الكتاب والحسبان، فأمر عبد الملك سليمان بن سعيد والي الأردن لعهده أن ينقل ديوان الشام إلى العربية، فأكمله لسنة من يوم ابتدائه، ووقف عليه سرجون كاتب عبد الملك، فقال لكتاب الروم: اطلبوا العيش في غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم.
وأما ديوان العراق فأمر الحجاج كاتبه صالح بن عبد الرحمن، وكان يكتب بالعربية والفارسية، ولقن ذلك عن زاذان فروخ كاتب الحجاج قبله، ولما قتل زاذان في حرب عبد الرحمن بن الأشعث استخلف الحجاج صالحاً هذا مكانه، وأمر أن ينقل الديوان من الفارسية إلى العربية ففعل، ورغم لذلك كتاب الفرس. وكان عبد الحميد بن يحيى يقول لله در صالح، ما أعظم منته على الكتاب!.
ثم جعلت هذه الوظيفة في دولة بني العباس مضافة إلى من كان له النظر فيه، كما كان شأن بني برمك وبني سهل بن نوبخت وغيرهم من وزراء الدولة.
وأما ما يتعلق بهذه الوظيفة من الأحكام الشرعية مما يختص بالجيش أو بيت المال في الدخل والخرج وتمييز النواحي بالصلح والعنوة، وفي تقليد هذه الوظيفة لمن يكون، وشروط الناظر فيها والكاتب وقوانين الحسبانات، فأمر راجع إلى كتب الأحكام السلطانية، وهي مسطورة هنالك وليست من غرض كتابنا، وإنما نتكلم فيها من حيث طبيعة الملك الذي نحن بصدد الكلام فيه.
وهذه الوظيفة جزء عظيم من الملك، بل هي ثالثة أركانه، لأن الملك لا بد له من الجند والمال والمخاطبة لمن غاب عنه، فاحتاج صاحب الملك إلى الأعوان في أمر السيف وأمر القلم وأمر المال، فينفرد صاحبها لذلك بجزء من رياسة الملك.
وكذلك كان الأمر في دولة بني أمية بالأندلس والطوائف بعدهم.
وأما في دولة الموحدين فكان صاحبها إنما يكون من الموحدين يستقل بالنظر في استخراج الأموال وجمعها وضبطها وتعقب نظر الولاة والعمال فيها، ثم تنفيذها على قدرها وفي مواقيتها. وكان يعرف بصاحب الأشغال، وكان ربما يليها في الجهات غير الموحدين ممن يحسنها.
ولما استبد بنو أبي حفص بإفريقية وكان شأن الجالية من الأندلس، فقدم عليهم أهل البيوتات وفيهم من كان يستعمل ذلك في الأندلس، مثل بني سعيد أصحاب القلعة جوار غرناطة المعروفين ببني أبي الحسن، فاستكفوا بهم في ذلك، وجعلوا لهم النظر في الأشغال، كما كان لهم بالأندلس، ودالوا فيها بينهم وبين الموحدين. ثم استقل بها أهل الحسبان والكتاب وخرجت عن الموحدين. ثم لما استغلظ أمر الحاجب ونفذ أمره في كل شأن من شؤون الدولة تعطل هذا الرسم، وصار صاحبه مرؤوساً للحاجب، وأصبح من جملة الجباة وذهبت تلك الرياسة التي كانت له في الدولة.
وأما دولة بني مرين لهذا العهد فحسبان العطاء والخراج مجموع لواحد، وصاحب هذه الرتبة هو الذي يصحح الحسبانات كلها، ويرجع إلى ديوانه ونظره معقب بنظر السلطان أو الوزير، وخطه معتبر في صحة الحسبان في الخراج والعطاء.
هذه أصول الرتب والخطط السلطانية، وهي الرتب العالية التي هي عامة النظر ومباشرة للسلطان.
وأما هذه الرتبة في دولة الترك فمتنوعة. وصاحب ديوان العطاء يعرف بناظر الجيش صاحب المال مخصوص باسم الوزير، وهو الناظر في ديوان الجباية العامة للدولة، وهو أعلى رتب الناظرين في الأموال، لأن النظر في الأموال عندهم يتنوع إلى رتب كثيرة لانفساح دولتهم، وعظمة سلطانهم، واتساع الأموال والجبايات عن أن يستقل بضبطها الواحد من الرجال، ولو بلغ في الكفاية مبالغه، فتعين للنظر العام منها هذا المخصوص باسم الوزير وهو مع ذلك رديف لمولى من موالي السلطان وأهل عصبيته وأرباب السيوف في الدولة، يرجع نظر الوزير إلى نظره، ويجتهد جهده في متابعته، ويسمى عندهم استاذ الدولة، وهو أحد الأمراء الأكابر في الدولة من الجند وأرباب السيوف. ويتبع هذه الخطة خطط عندهم آخرى كلها راجعة إلى الأموال والحسبان، مقصورة النظر على أمور خاصة مثل ناظر الخاص، وهو المباشر لأموال السلطان الخاصة به من إقطاعه أو سهمانه من أموال الخراج وبلاد الجباية مما ليس من أموال المسلمين العامة. وهو تحت يد الأمير استاذ الدار.
وإن كان الوزير من الجند فلا يكون لاستاذ الدار نظر عليه. وناظر الخاص تحت يد الخازن لأموال السلطان من مماليكه المسمى خازن الدار لاختصاص وظيفتهما بمال السلطان الخاص.
وهذا بيان هذه الخطة بدولة الترك بالمشرق بعدما قدمناه من أمرها بالمغرب. والله مصرف الأمور لا رب غيره.
ديوان الرسائل والكتابةهذه الوظيفة غير ضرورية في الملك لاستغناء كثير من الدول عنها رأساً كما في الدول العريقة في البداوة، التي لم يأخذها تهذيب الحضارة ولا استحكام الصنائع. وإنما أكد الحاجة إليها في الدولة الإسلامية شأن اللسان العربي والبلاغة في العبارة عن المقاصد. فصار الكتاب يؤدي كنه الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية في الأكثر. وكان الكاتب للأمير يكون من أهل نسبه ومن عظماء قبيله، كما كان للخلفاء وأمراء الصحابة بالشام والعراق، لعظم أمانتهم وخلوص أسرارهم. فلما فسد اللسان وصار صناعة اختص بمن يحسنه.. وكانت عند بني العباس رفيعة. وكان الكاتب يصدر السجلات مطلقة، ويكتب في آخرها اسمه، ويختم عليها بخاتم السلطان، وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو شارته، يغمس في طين أحمر مذاب بالماء، ويسمى طين الختم، ويطبع به على طرفي السجل عند طيه، وإلصاقه.
ثم صارت السجلات من بعدهم تصدر باسم السلطان، ويضع الكاتب فيها علامته أولاً أو آخراً على حسب الاختيار في محلها وفي لفظها. ثم قد تنزل هذه الخطة بارتفاع المكان عند السلطان لغير صاحبها من أهل المراتب في الدولة أو استبداد وزير عليه، فتصير علامة هذا الكتاب ملغاة الحكم بعلامة الرئيس عليه، يستدل بها فيكتب صورة علامته المعهودة، والحكم لعلامة ذلك الرئيس. كما وقع آخر الدولة الحفصية لما ارتفع شأن الحجابة، وصار أمرها إلى التفويض ثم الاستبداد، صار حكم العلامة التي للكاتب ملغى وصورتها ثابتة، اتباعاً لما سلف من أمرها. فصار الحاجب يرسم للكاتب إمضاء كتابه، ذلك بخط يصنعه ويتخير له من صيغ االإنفاذ ما شاء، فيأتمر الكاتب له، ويضع العلامة المعتادة. وقد يختص السلطان بنفسه بوضع ذلك إذا كان مستبداً بأمره قائماً على نفسه، فيرسم الأمر للكاتب ليضع علامته.
ومن خطط الكتابة التوقيع، وهو أن يجلس الكاتب بين يدي السلطان في مجالس حكمه وفصله ويوقع على القصص المرفوعة إليه أحكامها والفصل فيها، متلقاة من السلطان بأوجز لفظ وأبلغه: فإما أن تصدر كذلك، وإما أن يحذو الكاتب على مثالها في سجل يكون بيد صاحب القصة. ويحتاج الموقع إلى عارضة من البلاغة يستقيم بها توقيعه، وقد كان جعفر بن يحيى يوقع القصص بين يدي الرشيد ويرمي بالقصة إلى صاحبها، فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء في تحصيلها للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها، حتى قيل: إنها كانت تباع كل قصة منها بدينار. وهكذا كان شأن الدول.
واعلم أن صاحب هذه الخطة لا بد أن يتخير من أرفع طبقات الناس وأهل المروءة والحشمة منهم، وزيادة العلم وعارضة البلاغة، فإنه معرض للنظر في أصول العلم لما يعرض في مجالس الملوك ومقاصد أحكامهم، من أمثال ذلك مع ما تدعو إليه عشرة الملوك من القيام على الأداب والتخلق بالفضائل، مع ما يضطر إليه في الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها.
وقد تكون الرتبة في بعض الدول مستندة إلى أرباب السيوف، لما يقتضيه طبع الدولة من البعد عن معاناة العلوم لأجل سذاجة العصبية فيختص السلطان أهل عصبيته بخطط دولته وسائر رتبه، فيقلد المال والسيف والكتابة منهم. فأما رتبة السيف فتستغني عن معاناة العلم، وأما المال والكتابة فيضطر إلى ذلك للبلاغة في هذه والحسبان في الأخرى، فيختارون لها من هذه الطبقة ما دعت إليه الضرورة ويقلدونه، إلا أنه لا تكون يد آخر من أهل العصبية غالبة على يده، ويكون نظره متصرفاً عن نظره. كما هو في دولة الترك لهذا العهد بالمشرق، فإن الكتابة عندهم وإن كانت لصاحب الانشاء إلا أنه تحت يد أمير من أهل عصبية السلطان يعرف بالدويدار، وتعويل السلطان ووثوقه به واستنامتة في غالب أحواله إليه، وتعويله على الآخر في أحوال البلاغة وتطبيق المقاصد وكتمان الأسرار وغير ذلك من توابعها.
وأما الشروط المعتبرة في صاحب هذه الرتبة التي يلاحظها السلطان في اختياره وانتقائه من أصناف الناس فهي كثيرة، وأحسن من استوعبها عبد الحميد الكاتب في رسالته إلى الكتاب، وهي: رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الكتاب أما بعد حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة، وحاطكم ووفقكم وأرشدكم. فإن الله عز وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن بعد الملوك المكرمين أصنافاً وإن كانوا في الحقيقة سواء، وصرفهم في صنوف الصناعات، وضروب المحاولات، إلى أسباب معاشهم وأبواب أرزاقهم، فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات أهل الأدب والمروءات، والعلم والرزانة. بكم ينتظم للخلافة محاسنها وتستقيم أمورها. وبنصحائكم يصلح الله للخلق سلطانهم وتعمر بلدانهم. لا يستغني الملك عنكم، ولا يوجد كاف إلا منكم. فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون، وأبصارهم التي بها يبصرون، وألسنتهم التي بها ينطقون، وأيديهم التي بها يبطشون. فأمتعكم الله بما خصكم من فضل صناعتكم، ولا نزع عنكم ما أضفاه من النعمة عليكم. وليس أحد من أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتماع خلال الخير المحمودة، وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم.
أيها الكتاب: إذا كنتم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفتكم، فإن الكاتب يحتاج من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات أموره أن يكون حليماً في موضع الحلم، فهيماً في موضع الحكم، مقداماً في موضع الإقدام، محجماً في موضع الإحجام، مؤثراً للعفاف والعدل والإنصاف، كتوماً للأسرار، وفياً عند الشدائد، عالماً بما يأتي من النوازل، يضع الأمور مواضعها، والطوارق في أماكنها، قد نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمه، وإن لم يحكمه أخذ منه بمقدار ما يكتفي به، يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته، ما يرد عليه قبل وروده وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره، فيعد لكل أمر عدته وعتاده، ويهيىء لكل وجه هيئته وعادته.
فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الأداب، وتفقهوا في الدين. وابدؤوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض، ثم العربية فإنها ثقاف ألسنتكم، ثم أجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم، وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها، وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها، فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم، ولا تضيعوا النظر في الحساب فإنه قوام كتاب الخراج.
وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها ودنيها، وسفساف الأمور ومحاقرها، فإنها مذلة للرقاب، مفسدة للكتاب. ونزهوا صناعتكم عن الدناءة، واربؤوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه أهل الجهالات. وإياكم والكبر والسخف والعظمة، فإنها عداوة مجتلبة من غير إحنة. وتحابوا في الله عز وجل في صناعتكم، وتواصوا عليها بالذي هو أليق لأهل الفضل والعدل والنبل من سلفكم. وإن نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه، وواسوه حتى يرجع إليه حاله ويثوب إليه أمره. وإن أقعد أحداً منكم الكير عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه واستظهروا بفضل تجربته وقديم معرفته، وليكن الرجل منكم على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحوط منه على ولده وأخيه. فإن عرضت في الشغل محمدة فلا يصرفها إلا إلى صاحبه، وإن عرضت مذمة فليحملها هو من دونه. وليحذر السقطة والزلة والملل عند تغير الحال. فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى القراء، وهو لكم أفسد منه لهم. فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه من يبذل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه، فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه وشكره واحتماله وخيره ونصيحته وكتمان سره وتدبير أمره ما هو جزاء لحقه، ويصدق ذلك بفعاله عند الحاجة إليه، والاضطرار إلى ما لديه. فاستشعروا ذلك. وفقكم الله من أنفسكم. في حالة الرخاء والشدة والحرمان والمواساة والإحسان والسراء والضراء. فنعمت الشيمة هذه، من وسم بها من أهل هذه الصناعة الشريفة. وإذا ولي الرجل منكم أو صير إليه من أمر خلق الله وعياله أمر فليراقب الله عز وجل، وليؤثر طاعته وليكن مع الضعيف رفيقاً وللمظلوم منصفاً، فإن الخلق عيال الله، وأحبهم إليه أرفقهم بعياله.
ثم ليكن بالعدل حاكماً، وللأشراف مكرماً، وللفيء موفراً، وللبلاد عامراً، وللرعية متألفاً، وعن أذاهم متخلفاً وليكن في مجلسه متواضعاً حليماً، وفي سجلات خراجه واستقضاء حقوقه رفيقاً.
وإذا صحب أحدكم رجلاً فليختبر خلائقه، فإذا عرف حسنها وقبيحها أعانه على ما يوافقه من الحسن، واحتال على صرفه عما يهواه من القبح بألطف حيلة وأجمل وسيلة. وقد علمتم أن سائس البهيمة إذا كان بصيراً بسياستها التمس معرفة أخلاقها: فإن كانت رموحاً لم يهجها إذا ركبها، وإن كانت شبوباً اتقاها من بين يديها، وإن خاف منها شروداً توقاها من ناحية رأسها، وإن كانت حروناً قمع برفق هواها في طرقها، فإن استمرت عطفها يسيراً فيسلس له قيادها. وفي هذا الوصف من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وجربهم وداخلهم. والكاتب، لفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن يجاوره من الناس ويناظره، ويفهم عنه أو يخاف سطوته، أولى بالرفق لصاحبه، ومداراته وتقويم أوده من سائس البهيمة التي لا تحير جواباً، ولا تعرف صواباً، ولا تفهم خطاباً، إلا بقدر ما يصيرها إليه صاحبها الراكب عليها. إلا فارفقوا رحمكم الله في النظر، واعملوا ما أمكنكم فيه من الروية والفكر تأمنوا بإذن الله ممن صحبتموه النبوة والاستثقال والجفوة، ويصير منكم إلى الموافقة، وتصيروا منه إلى المواخاة والشفقة إن شاء الله.
ولا يجاوزن الرجل منكم في هيئة مجلسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربه وبنائه وخدمه، وغير ذلك من فنون أمره قدر حقه، فإنكم مع ما فضلكم الله به من شرف صنعتكم خدمة لا تحملون في خدمتكم على التقصير، حفظة لا تحتمل منكم أفعال التضييع والتبذير. واستعينوا على عفافكم بالقصد في كل ما ذكرته لكم وقصصته عليكم. واحذروا متالف السرف وسوء عاقبة الترف، فإنهما يعقبان الفقر ويذلان الرقاب . ويفضحان أهلهما ولا سيما الكتاب وأرباب الأداب.
وللأمور أشباه وبعضها دليل على بعض، فاستدلوا على مؤتنف أعمالكم بما سبقت إليه تجربتكم. ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجة، وأصدقها حجة، وأحمدها عاقبة. واعلموا أن للتدبير آفة متلفة وهو الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ علمه ورويته. فليقصد الرجل منكم في مجلسه قصد الكافي من منطقه، وليوجز في ابتدائه وجوابه، وليأخذ بمجامع حججه، فإن ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للشاغل عن إكثاره. وليضرع إلى الله في صلة توفيقه وإمداده بتسديده مخافة وقوعه في الغلط المضر ببدنه وعقله وآدابه. فإنه إن ظن منكم ظان أو قال قائل إن الذي برز من جميل صنعته، وقوة حركته إنما هو بفضل حيلته وحسن تدبيره، فقد تعرض بحسن ظنه أو مقالته إلى أن يكله الله عز وجل إلى نفسه، فيصير منها إلى غير كاف، وذلك على من تأمله غير كاف. ولا يقول أحد منكم إنه أبصر بالأمور وأحمل لعبء التدبير من مرافقه في صناعته ومصاحبه في خدمته، فإن أعقل الرجلين عند ذوي الألباب من رمى بالعجب وراء ظهره، ورأى أن أصحابه أعقل منه وأجمل في طريقته. وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم الله جل ثناؤه من غير اغترار برأيه ولا تزكية لنفسه، ولا يكاثرعلى أخيه أو نظيره وصاحبه وعشيره. وحمد الله واجب على الجميع، وذلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته والتحدث بنعمته.
وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به المثل: من تلزمه النصيحة يلزمه العمل. وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه بعد الذي فيه من ذكر الله عز وجل. فلذلك جعلته آخره وتممته به.
تولانا الله وإياكم يا معشر الطلبة والكتبة بما يتولى به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده، فإن ذلك إليه وبيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشرطةويسمى صاحبها لهذا العهد بإفريقية الحاكم، وفي دولة أهل الأندلس صاحب المدينة، وفي دولة الترك الوالي. وهي وظيفة مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة، وحكمه نافذ في صاحبها في بعض الأحيان. وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في حال استبدائها أولاً ثم الحدود بعد استيفائها. فإن التهم التي تعرض في، الجرائم لا نظر للشرع إلا في استيفاء حدودها، وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها بإقرار يكرهه عليه الحاكم إذا احتفت به القرائن لما توجبه المصلحة العامة في ذلك. فكان الذي يقوم بهذا الاستبداء وباستيفاء الحدود بعده إذا تنزه عنه القاضي يسمى صاحب الشرطة، وربما جعلوا إليه النظر في الحدود والدماء بإطلاق، وأفردوها من نظر القاضي. ونزهوا هذه المرتبة وقلدوها كبار القواد وعظماء الخاصة من مواليهم. ولم تكن عامة التنفيذ في طبقات الناس، إنما كان حكمهم على الدهماء وأهل الريب، والضرب على أيدي الرعاع والفجرة.
ثم عظمت نباهتها في دولة بني أمية بالأندلس، ونوعت إلى شرطة كبرى وشرطة صغرى. وجعل حكم الكبرى على الخاصة والدهماء. وجعل له الحكم على أهل المراتب السلطانية والضرب على أيديهم في الظلامات، وعلى أيدي أقاربهم ومن إليهم من أهل الجاه. وجعل صاحب الصغرى مخصوصاً بالعامة. ونصب لصاحب الكبرى كرسي بباب دار السلطان ورجال يتبؤون المقاعد بين يديه، فلا يبرحون عنها إلا في تصريفه. وكانت ولايتها للأكابر من رجالات الدولة حتى كانت ترشيحاً للوزارة والحجابة.
وأما في دولة الموحدين بالمغرب فكان لها حظ من التنويه وإن لم يجعلوها عامة.
وكان لا يليها إلا رجالات الموحدين وكبراؤهم. ولم يكن له التحكم على أهل المراتب السلطانية. ثم فسد اليوم منصبها وخرجت عن رجال الموحدين وصارت ولايتها لمن قام بها من المصطنعين.
وأما في دولة بني مرين لهذا العهد بالمشرق فولايتها في بيوت من مواليهم وأهل اصطناعهم، وفي دولة الترك بالمشرق في رجالات الترك أو أعقاب أهل الدولة قبلهم من الكرد، يتخيرونهم لها في النظر بما يظهر منهم من الصلابة والمضاء في الأحكام لقطع مواد الفساد وحسم أبواب الدعارة، وتخريب مواطن الفسوق وتفريق مجامعه، مع إقامة الحدود الشرعية والسياسية كما تقتضيه رعاية المصالح العامة في المدينة. والله مقلب الليل والنهار، وهو العزيز الجبار، والله تعالى أعلم.
قيادة الأساطيلوهي من مراتب الدولة وخططها في ملك المغرب وإفريقية، ومرؤوسة لصاحب السيف وتحت حكمه في كثير من الأحوال. ويسمى صاحبها في عرفهم الملند بتفخيم اللام منقولاً من لغة الأفرنجة فإنه اسمها في اصطلاح لغتهم. وإنما اختصت هذه المرتبة بملك إفريقية والمغرب لأنهما جميعاً على ضفة البحر الرومي من جهة الجنوب، وعلى عدوته الجنوبية بلاد البربر كلهم من سبتة إلى الإسكندرية إلى الشام، وعلى عدوته الشمالية بلاد الأندلس والإفرنجة والصقالبة والروم إلى بلاد الشام أيضاً ويسمى البحر الرومي والبحر الشامي نسبة إلى أهل عدوته. والساكنون بسيف هذا البحر وسواحله من عدوتيه يعانون من أحواله ما لا تعانيه أمة من أمم البحار. فقد كانت الروم والإفرنجة والقوط بالعدوة الشمالية من هذا البحر الرومي، وكانت أكثر حروبهم ومتاجرهم في السفن، فكانوا مهرة في ركوبه والحرب في أساطيله. ولما أسف من أسف منهم إلى ملك العدوة الجنوبية، مثل الروم إلى إفريقية والقوط إلى المغرب، أجازوا في الأساطيل وملكوها وتغلبوا على البربر بها، وانتزعوا من أيديهم أمرها، وكان لهم بها المدن الحافلة مثل قرطاجنة وسبيطلة وجلولاء ومرناق وشرشال وطنجة. وكان صاحب قرطاجنة من قبلهم يحارب صاحب رومة. ويبعث الأساطيل لحربه مشحونة بالعساكر والعدد فكانت هذه عادة لأهل هذا البحر الساكنين حفافيه معروفة في القديم والحديث.
ولما ملك المسلمون مصر كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، أن صف لي البحر، فكتب إليه: " إن البحر خلق عظيم، يركبه خلق ضعيف، دود على عود " . فأوعز حينئذ بمنع المسلمين من ركوبه. ولم يركبه أحد من العرب إلا من افتأت على عمر في ركوبه ونال من عقابه، كما فعل بعرفجة بن هرثمة الأزدي سيد بجيلة لما أغزاه عمان، فبلغه غزوه في البحر، فأنكر عليه وعنفه أنه ركب البحر للغزو. ولم يزل الشأن ذلك حتى إذا كان لعهد معاوية أذن للمسلمين في ركوبه والجهاد على أعواده. والسبب في ذلك أن العرب كانوا لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرة في ثقافته وركوبه، والروم والإفرنجة لممارستهم أحواله ومرباهم في التقلب على أعواده مرنوا عليه وأحكموا الدراية بثقافته.
فلما استقر الملك للعرب وشمخ سلطانهم وصارت أمم العجم خولاً لهم وتحت أيديهم، وتقرب كل ذي صنعة إليهم بمبلغ صناعته، واستخدموا من النواتية في حاجاتهم البحرية أمماً وتكررت ممارستهم للبحر وثقافته، استحدثوا بصراء بها، فشرهوا إلى الجهاد فيه، وأنشؤوا السفن فيه والشواني، وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح وأمطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر، واختصوا بذلك من ممالكهم وثغورهم ما كان أقرب لهذا البحر، وعلى حافته مثل الشام وإفريقية والمغرب والأندلس. وأوعز الخليفة عبد الملك إلى حسان بن النعمان عامل إفريقية باتخاذ دار الصناعة بتونس لإنشاء الألات البحرية حرصاً على مراسم الجهاد. ومنها كان فتح صقلية أيام زيادة الله الأول بن إبراهيم بن الأغلب على يد أسد بن الفرات شيخ الفتيا، وفتح قوصرة أيضاً في أيامه بعد أن كان معاوية بن حديج أغزي صقلية أيام معاوية بن أبي سفيان فلم يفتح الله على يديه، وفتحت على يد ابن الأغلب وقائده أسد بن الفرات. وكانت من بعد ذلك أساطيل إفريقية والأندلس في دولة العبيديين والأمويين تتعاقب إلى بلادهما في سبيل الفتنة، فتجوس خلال السواحل بالإفساد والتخريب. وانتهى أسطول الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر إلى مائتي مركب أو نحوها، وأسطول إفريقية كذلك مثله أو قريباً منه، وكان قائد الأساطيل بالأندلس ابن رماحس، ومرفأها للحط والإقلاع بجاية والمرية. وكانت أساطيلها مجتمعة من سائر الممالك، من كل بلد يتخذ فيه السفن أسطول، يرجع نظره إلى قائد من النواتية يدبر أمر حربه وسلاحه ومقاتلته، ورئيس يدبر أمر جريته بالريح أو بالمجاذيف وأمر إرسائه في مرفئه. فإذا اجتمعت الأساطيل لغزو محتفل أو غرض سلطاني مهم عسكرت بمرفئها المعلوم وشحنها السلطان برجاله وأنجاد عساكره ومواليه، وجعلهم لنظر أمير واحد من أعلى طبقات أهل مملكته يرجعون كلهم إليه، ثم يسرحهم لوجههم وينتظر إيابهم بالفتح والغنيمة.
وكان المسلمون لعهد الدولة الإسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانبه، وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه، فلم يكن للأمم النصرانية قبل بأساطيلهم بشيء من جوانبه، وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم، فكانت لهم المقامات المعلومة من الفتح والغنائم، وملكوا سائر الجزائر المنقطعة عن السواحل فيه، مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية وصقلية وقوصرة ومالطة وأقريطش وقبرص وسائر ممالك الروم والإفرنج. وكان أبو القاسم الشيعي وأبناؤه يغزون أساطيلهم من المهدية جزيرة جنوة فتنقلب بالظفر والغنيمة. وافتتح مجاهد العامري صاحب دانية من ملوك الطوائف جزيرة سردانية في أساطيله سنة خمس وأربعمائة، وارتجعها النصارى لوقتها. والمسلمون خلال ذلك كله قد تغلبوا على كثيبر من لجة هذا البحر، وسارت أساطيلهم فيهم جائية وذاهبة، والعساكر الإسلامية تجيز البحر في الأساطيل من صقلية إلى البر الكبير المقابل لها من العدوة الشمالية، فتوقع بملوك الإفرنج وتثخن في ممالكهم، كما وقع في أيام بني الحسين ملوك صقلية القائمين فيها بدعوة العبيديين، وانحازت أمم النصرانية بأساطيلهم إلى الجانب الشمالي الشرقي منه، من سواحل الإفرنجة والصقالبة وجزائر الرومانية لا يعدونها. وأساطيل المسلمين قد ضريت عليهم ضراء الأسد على فريسته، وقد ملأت الأكثر من بسيط هذا البحر عدة وعدداً، واختلفت في طرقه سلماً وحرباً، فلم تسبح للنصرانية فيه ألواح.
حتى إذا أدرك الدولة العبيدية والأموية الفشل والوهن، وطرقها الاعتلال مد النصارى أيديهم إلى جزائر البحر الشرقية مثل صقلية وإقريطش ومالطة، فملكوها. ثم ألحوا على سواحل الشام في تلك الفترة وملكوا طرابلس وعسقلان وصور وعكا، واستولوا على جميع الثغور بسواحل الشام، وغلبوا على بيت المقدس وبنوا عليه كنيسة لإظهار دينهم وعبادتهم، وغلبوا بني خزرون على طرابلس، ثم على قابس وصفاقس ووضعوا عليهم الجزية، ثم ملكوا المهدية مقر ملوك العبيديين من يد أعقاب بلكين بن زيري، وكانت لهم في المائة الخامسة الكرة بهذا البحر. وضعف شأن الأساطيل في دولة مصر والشام إلى أن انقطع، ولم يعتنوا بشيء من أمره لهذا العهد، بعد أن كان لهم به في الدولة العبيدية عناية تجاوزت الحد كما هو معروف في أخبارهم. فبطل رسم هذه الوظيفة هنالك، وبقيت بإفريقية والمغرب فصارت مختصة بها. وكان الجانب الغربي من هذا البحر لهذا العهد موفور الأساطيل ثابت القوة، لم يتحيفه عدو، ولا كانت لهم به كرة. فكان قائد الأسطول به لعهد لمتونة بني ميمون رؤساء جزيرة قادس، ومن أيديهم أخذها عبد المؤمن بتسليمهم وطاعتهم، وانتهى عدد أساطيلهم إلى المائة من بلاد العدوتين جميعاً.
ولما استفحلت دولة الموحدين في المائة السادسة وملكوا العدوتين أقاموا خطة هذا الأسطول على أتم ما عرف وأعظم ما عهد. وكان قائد أسطولهم أحمد الصقلي، أصله من صدغيار الموطنين بجزيرة جربة من سرويكش، أسره النصارى من سواحلها وربي عندهم، واستخلصه صاحب صقلية واستكفاه، ثم هلك وولي ابنه فأسخطه ببعض النزعات، وخشي على نفسه ولحق بتونس، ونزل على السيد بها من بني عبد المؤمن، وأجاز إلى مراكش، فتلقاه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بالمبرة والكرامة، وأجزل الصلة وقلده أمر أساطيله فجلى في جهاد أمم النصرانية، وكانت له آثار وأخبار ومقامات مذكورة في دولة الموحدين. وانتهت أساطيل المسلمين على عهده في الكثرة والاستجادة إلى ما لم تبلغه من قبل ولا بعد فيما عهدناه.
ولما قام صلاح الدين يوسف بن أيوب ملك مصر والشام لعهده باسترجاع ثغور الشام من يد أمم النصرانية، وتطهير بيت المقدس، تتابعت أساطيلهم بالمدد لتلك الثغور من كل ناحية قريبة لبيت المقدس الذي كانوا قد استولوا عليه، فأمدوهم بالعدد والأقوات، ولم تقاومهم أساطيل الإسكندرية لاستمرار الغلب لهم في ذلك الجانب الشرقي من البحر، وتعدد أساطيلهم فيه، وضعف المسلمين منذ زمان طويل عن ممانعتهم هناك كما أشرنا إليه قبل. فأوفد صلاح الدين على أبي يعقوب المنصور سلطان المغرب لعهده من الموحدين رسوله عبد الكريم بن منقذ من بيت بني منقذ ملوك شيزر، وكان ملكها من أيديهم وأبقى عليهم في دولته، فبعث عبد الكريم منهم هذا إلى ملك المغرب طالباً مدد الأساطيل لتجول في البحر بين أساطيل الأجانب وبين مرامهم من إمداد النصرانية بثغور الشام، وأصحبه كتابه إليه في ذلك، من إنشاء الفاضل البيساني يقول في افتتاحه: " فتح الله لسيدنا أبواب المناجح والميامن " حسبما نقله العماد الأصفهاني في كتاب الفتح القدسي. فنقم عليهم المنصور تجافيهم عن خطابه بأمير المؤمنين وأسرها في نفسه، وحملهم على مناهج البر والكرامة، وردهم إلى مرسلهم، ولم يجبه إلى حاجته من ذلك. وفي هذا دليل على اختصاص ملك المغرب بالأساطيل وما حصل للنصرانية في الجانب الشرقي من هذا البحر من الإستطالة وعدم عناية الدول بمصر والشام لذلك العهد وما بعده بشأن الأساطيل البحرية والاستعداد منها للدولة.
ولما هلك أبو يعقوب المنصور واعتلت دولة الموحدين واستولت أمم الجلالقة على الأكثر من بلاد الأندلس، وألجأوا المسلمين إلى سيف البحر، وملكوا الجزائر التي بالجانب الغربي من البحر الرومي، قويت ريحهم في بسيط هذا البحر، واشتدت شوكتهم وكثرت فيه أساطيلهم، وتراجعت قوة المسلمين فيه إلى المساواة معهم، كما وقع لعهد السلطان أبي الحسن ملك زناتة بالمغرب، فإن أساطيله كانت عند مرامه الجهاد مثل عدة النصرانية وعديدهم.
ثم تراجعت عن ذلك قوة المسلمين في الأساطيل لضعف الدولة ونسيان عوائد البحر، بكثرة العوائد البدوية بالمغرب وانقطاع العوائد الأندلسية. ورجع النصارى فيه إلى دينهم المعروف من الدربة فيه والمران عليه والبصر بأحواله وغلب الأمم في لجته وعلى أعواده. وصار المسلمون فيه كالأجانب إلا قليلاً من أهل البلاد الساحلية لهم المران عليه لو وجدوا كثرة من الأمصار والأعوان، أو قوه من الدولة تستجيش لهم أعواناً وتوضح لهم في هذا الغرض مسلكاً. وبقيت الرتبة لهذا العهد في الدولة الغربية محفوظة، والرسم في معاناة الأساطيل بالإنشاء والركوب معهوداً، لما عساه أن تدعو إليه الحاجة من الأغراض السلطانية في البلاد البحرية. والمسلمون يستهبون الريح على الكفر وأهله. فمن المشتهر بين أهل المغرب عن كتب الجدثان انه لا بد للمسلمين من الكرة على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلاد الإفرنجة، وإن ذلك يكون في الأساطيل. والله ولي المؤمنين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الفصل الخامس والثلاثون
في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول
اعلم أن السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة يستعين بهما على أمره. إلا أن الحاجة في أول الدولة إلى السيف ما دام أهلها في تمهيد أمرهم أشد من الحاجة إلى القلم، لأن القلم في تلك الحال خادم فقط منفذ للحكم السلطاني، والسيف شريك في المعونة. وكذلك في آخر الدولة حيث تضعف عصبيتها كما ذكرناه، ويقل أهلها بما ينالهم من الهرم الذي قدمناه، فتحتاج الدولة إلى الاستظهار بأرباب السيوف وتقوى الحاجة إليهم في حماية الدولة، والمدافعة عنها، كما كان الشأن أول الأمر في تمهيدها. فيكون للسيف مزية على القلم في الحالتين. ويكون أرباب السيف حينئذ أوسع جاهاً وأكثر نعمة وأسنى إقطاعاً. وأما في وسط الدولة فيستغني صاحبها بعض الشيء عن السيف لأنه قد تمهد أمره، ولم يبق همه إلا في تحصيل ثمرات الملك من الجباية والظبط ومباهاة الدول وتنفيذ الأحكام، والقلم هو المعين له في ذلك، فتعظم الحاجة إلى تصريفه، وتكون السيوف مهملة في مضاجع أغمادها، إلا إذا نابت نائبة أو دعيت إلى سد فرجة، وما سوى ذلك فلا حاجة إليها. فيكون أرباب الأقلام في هذه الحاجة أوسع جاهاً، وأعلى رتبة، وأعظم نعمة وثروة، وأقرب من السلطان مجلساً، وأكثر إليه تردداً وفي خلواته نجياً، لأنه حينئذ آلته التي بها يستظهر على تحصيل ثمرات ملكه، والنظر في أعطافه، وتثقيف أطرافه، والمباهاة بأحواله، ويكون الوزراء حينئذ وأهل السيوف مستغنى عنهم، مبعدين عن باطن السلطان، حذرين على أنفسهم من بوادره. وفي معنى ذلك ما كتب به أبو مسلم للمنصور حين أمره بالقدوم: " أما بعد فإنه مما حفظناه من وصايا الفرس، أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء " . سنة الله في عباده، والله سبحانه وتعالى أعلم.الفصل السادس والثلاثون
في شارات الملك والسلطان الخاصة به
اعلم أن للسلطان شارات وأحوالاً تقتضيها الأبهة والبذخ فيختص بها ويتميز بانتحالها عن الرعية والبطانة وسائر الرؤساء في دولته. فلنذكر ما هو مشتهر منها بمبلغ المعرفة، " وفوق كل ذي علم عليم " .الآلة: فمن شارات الملك اتخاذ الألة من نشر الألوية والرايات وقرع الطبول والنفخ في الأبواق والقرون. وقد ذكر أرسطو في الكتاب المنسوب إليه في السياسة، أن السر في ذلك إرهاب العدو في الحرب، فإن الأصوات الهائلة لها تأثير في النفوس بالروعة. ولعمري إنه
أمر وجداني في مواطن الحرب يجده كل أحد من نفسه. وهذا السبب الذي ذكره أرسطو - إن كان ذكره - فهو صحيح ببعض الاعتبارات. وأما الحق في ذلك فهو أن النفس عند سماع النغم والأصوات يدركها الفرح والطرب بلا شك، فيصيب مزاج الروح نشوة يستسهل بها الصعب، ويستميت في ذلك الوجه الذي هو فيه. وهذا موجود حتى في الحيوانات العجم، بانفعال الإبل بالحداء، والخيل بالصفير والصريخ كما علمت. ويزيد ذلك تأثيراً إذا كانت الأصوات متناسبة كما في الغناء. وأنت تعلم ما يحدث لسامعه من مثل هذا المعنى. ولأجل ذلك تتخذ العجم في مواطن حروبهم الألات الموسيقية لا طبلاً ولا بوقاً، فيحدق المغنون بالسلطان في موكبه بآلاتهم، ويغنون، فيدركون نفوس الشجعان بضربهم إلى الاستماتة. ولقد رأينا في حروب العرب من يتغنى أمام الموكب بالشعر ويطرب، فتجيش همم الأبطال بما فيها، ويسارعون إلى مجال الحرب، وينبعث كل قرن إلى قرنه. وكذلك زناتة من أمم المغرب. يتقدم الشاعر عندهم أمام الصفوف، ويتغنى فيدرك بغنائه الجبال الرواسي، ويبعث على الاستماتة من لا يظن بها، ويسمون ذلك الغناء تاصوكايت. وأصله كله قرح يحدث في النفس فتنبعث عنه الشجاعة كما تنبعث عن نشوة الخمر بما حدث عنها من الفرح. والله أعلم.
وأما تكثير الرايات وتلوينها وإطالتها فالقصد به التهويل لا أكثر وربما يحدث في النفوس من التهويل زيادة في الإقدام، وأحوال النفوس وتلوناتها غريبة. والله الخلاق العليم. ثم إن الملوك والدول يختلفون في اتخاذ هذه الشارات، فمنهم مكثر ومنهم مقلل بحسب اتساع الدولة وعظمها. فأما الرايات فإنها شعار الحروب من عهد الخليقة، ولم تزل الأمم تعقدها في مواطن الحروب والغزوات، لعهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء. وأما قرع الطبول والنفخ في الأبواق فكان المسلمون لأول الملة متجافين عنه، تنزهاً عن غلظة الملك ورفضاً لأحواله، واحتقاراً، لأبهته التي ليست من الحق في شيء. حتى إذ ا انقلبت الخلافة ملكاً وتبجحوا بزهرة الدنيا ونعيمها، ولابسهم الموالي من الفرس والروم أهل الدول السالفة، وأروهم ما كان أولئك ينتحلونه من مذاهب البذخ والترف، فكان مما استحسنوه اتخاذ الألة فأخذوها، وأذنوا لعمالهم في اتخاذها تنويهاً بالملك وأهله. فكثيراً ما كان العامل صاحب الثغر أو قائد الجيش يعقد له الخليفة من العباسيين أو العبيديين لواءه، ويخرج إلى بعثه أو عمله من دار الخليفة أو داره في موكب من أصحاب الرايات والآلات، فلا يميز بين موكب العامل والخليفة إلا بكثرة الألوية وقلتها، أو بما اختص به الخليفة من الألوان لرايته كالسواد في رايات بني العباس، فإن راياتهم كانت سوداً حزناً على شهدائهم من بني هاشم، ونعياً على بني أمية في قتلهم، ولذلك سموا المسودة.
ولما افترق أمر الهاشميين وخرج الطالبيون على العباسيين في كل جهة وعصر، ذهبوا إلى مخالفتهم في ذلك فاتخذوا الرايات بيضاً وسموا المبيضة لذلك سائر أيام العبيديين، ومن خرج من الطالبيين في ذلك العهد بالمشرق، كالداعي بطبرستان وداعي صعدة أو من دعا إلى بدعة الرافضة من غيرهم كالقرامطة.
ولما نزع المأمون عن لبس السواد وشعاره في دولته عدل إلى لون الخضرة، فجعل رايته خضراء.
وأما الاستكثار منها فلا ينتهي إلى حد، وقد كانت آلة العبيديين لما خرج العزيز إلى فتح الشام خمسمائة من البنود وخمسمائة من الأبواق.
وأما ملوك البربر بالمغرب من صنهاجة وغيرها فلم يختصوا بلون واحد، بل وشوها بالذهب واتخذوها من الحرير الخالص ملونة، واستمروا على الإذن فيها لعمالهم. حتى إذا جاءت دولة الموحدين ومن بعدهم من زناتة قصروا الألة من الطبول والبنود على السلطان، وحظروها على من سواه من عماله، وجعلوا لها موكباً خاصاً يتبع أثر السلطان في مسيره يسمى الساقة. وهم فيه بين مكثر ومقلل باختلاف مذاهب الدول في ذلك: فمنهم من يقتصر على سبع من العدد تبركاً بالسبعة كما هو في دولة الموحدين، وبني الأحمر بالأندلس، ومنهم من يبلغ العشرة والعشرين كما هو عند زناتة. وقد بلغت في أيام السلطان أبي الحسن فيما أدركناه مائة من الطبول ومائة من البنود ملونة بالحرير منسوجة بالذهب، ما بين كبير وصغير. ويأذنون للولاة والعمال والقواد في اتخاذ راية واحدة صغيرة من الكتان بيضاء وطبل صغير أيام الحرب لا يتجاوزون ذلك.
وأدا دولة الترك لهذا العهد بالمشرق فيتخذون أولاً راية واحدة عظيمة، وفي رأسها خصلة كبيرة من الشعر يسمونها الشالش والجتر، وهي شعار السلطان عندهم، ثم تتعدد الرايات ويسمونها السناجق، واحدها سنجق وهي الراية بلسانهم. وأما الطبول فيبالغون في الاستكثار منها ويسمونها الكوسات، ويبيحون لكل أمير أو قائد عسكر أن يتخذ من ذلك ما يشاء إلا الجتر فإنه خاص بالسلطان.
وأما الجلالقة لهذا العهد من أمم الإفرنجة بالأندلس، فأكثر شأنهم اتخاذ الألوية القليلة ذاهبة في الجو صعداً ومعها قرع الأوتار من الطنابير، ونفخ الغيطات، يذهبون فيها مذهب الغناء وطريقه في مواطن حروبهم، وهكذا يبلغنا عنهم وعمن وراءهم من ملوك العجم. " ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين " .
السرير: وأما السرير والمنبر والتخت والكرسي فهي أعواد منصوبة أو أرائك منضدة لجلوس السلطان عليها مرتفعاً عن أهل مجلسه أن يساويهم في الصعيد. ولم يزل ذلك من سنن الملوك قبل الإسلام، وفي دول العجم. وقد كانوا يجلسون على أسرة الذهب. وكان لسليمان بن داود صلوات الله عليهما وسلامه كرسي وسرير من عاج، مغشى بالذهب. إلا أنه لا تأخذ به الدول إلا بعد الاستفحال والترف شأن الأبهة كلها كما قلناه. وأما في أول الدولة عند البداوة فلا يتشوفون إليه.
وأول من اتخذه في الإسلام معاوية واستأذن الناس فيه، وقال لهم: إني قد بدنت فأذنوا له، فاتخذه واتبعه الملوك الإسلاميون فيه وصار من منازع الأبهة. ولقد كان عمرو بن العاص بمصر يجلس في قصره على الأرض مع العرب، ويأتيه المقوقس إلى قصره ومعه سرير من الذهب محمول على الأيدي لجلوسه شأن الملوك، فيجلس عليه وهو أمامه، ولا يغيرون عليه وفاء له بما عقد معهم من الذمة واطراحاً لأبهة الملك. ثم كان بعد ذلك لبني العباس والعبيديين وسائر ملوك الإسلام شرقاً وغرباً من الأسرة والمنابر والتخوت ما عفا عن الأكاسرة والقياصرة. والله مقلب الليل والنهار.
السكة: وهي الختم على الدنانير والدراهم المتعامل بها بين الناس بطابع حديد ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة، ويضرب بها على الدينار أو الدرهم، فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة، بعد أن يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس في خلوصه بالسبك مرة بعد أخرى، وبعد تقدير أشخاص الدراهم والدنانير بوزن معين صحيح يصطلح عليه، فيكون التعامل بها عدداً، وإن لم تقدر أشخاصها يكون التعامل بها وزناً. ولفظ السكة كان اسماً للطابع، وهي الحديدة المتخذة لذلك، ثم نقل إلى أثرها وهي النقوش الماثلة على الدنانير والدراهم، ثم نقل إلى القيام على ذلك، والنظر في استيفاء حاجاته وشروطه، وهي الوظيفة، فصار علماً عليها في عرف الدول. وهي وظيفة ضرورية للملك إذ بها يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في النقود عند المعاملات، ويتقون في سلامتها الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة. وكان ملوك العجم يتخذونها وينقشون فيها تماثيل تكون مخصوصة بها، مثل تمثال السلطان لعهدها أو تمثيل حصن أو حيوان أو مصنوع أو غير ذلك، ولم يزل هذا الشأن عند العجم إلى آخر أمرهم.
ولما جاء الإسلام أغفل ذلك لسذاجة الدين وبداوة العرب. وكانوا يتعاملون بالذهب والفضة وزناً، وكانت دنانير الفرس ودراهمهم بين أيديهم يردونها في معاملتهم إلى الوزن ويتصارفون بها بينهم، إلى أن تفاحش الغش في الدنانير والدراهم، لغفلة الدولة عن ذلك، وأمر عبد الملك الحجاج، على ما نقل سعيد بن المسيب وأبو الزناد، بضرب الدراهم وتمييز المغشوش من الخالص، وذلك سنة أربع وسبعين، وقال المدايني سنة خمس وسبعين، ثم أمر بصرفها في سائر النواحي سنة ست وسبعين، وكتب عليها: " الله أحد الله الصمد " .
ثم ولي ابن هبيرة العراق أيام يزيد بن عبد الملك، فجود السكة، ثم بالغ خالد القسرفي في تجويدها، ثم يوسف بن عمر بعده. وقيل: أول من ضرب الدنانير والدراهم مصعب بن الزبير بالعراق سنة سبعين بأمر أخيه عبد الله لما ولي الحجاز، وكتب عليها في أحد الوجهين: " بركة الله " وفي الآخر " اسم الله " ، ثم غيرها الحجاج بعد ذلك بسنة، وكتب عليها اسم الحجاج وقدر وزنها على ما كانت استقرت أيام عمر. وذلك أن الدرهم كان وزنه أول الإسلام ستة دوانق، والمثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم، فتكون عشرة دراهم بسبعة مثاقيل. وكان السبب في ذلك ان أوزان الدرهم أيام الفرس كانت مختلفة وكان منها على وزن المثقال عشرون قيراطاً، ومنها اثنا عشر، ومنها عشرة، فلما احتيج إلى تقديره في الزكاة أخذ الوسط وذلك اثنا عشر قيراطاً، فكان المثقال درهماً وثلاثة أسباع درهم. وقيل كان منها البغلي بثمانية دوانق، والطبري أربعة دوانق، والمغربي ثمانية دوانق، واليمني ستة دوانق، فأمر عمر أن ينظر الأغلب في التعامل، فكان البغلي والطبري وهما اثنا عشر دانقاً. وكان الدرهم ستة دوانق، وإن زدت ثلاثة أسباعه كان مثقالاً، وإذا أنقصت ثلاثة أعشار المثقال كان درهماً. فلما رأى عبد الملك اتخاذ السكة لصيانة النقدين الجاريين في معاملة المسلمين من الغش عين مقدارها على هذا الذي استقر لعهد عمر رضي الله عنه، واتخذ طابع الحديد واتخذ فيه كلمات لا صوراً، لأن العرب كان الكلام والبلاغة أقرب مناحيهم وأظهرها، مع أن الشرع ينهى عن الصور. فلما فعل ذلك استمر بين الناس في أيام الملة كلها. وكان الدينار والدرهم على شكلين مدورين، والكتابة عليهما في دوائر متوازية يكتب فيها من أحد الوجهين أسماء الله تهليلاً وتحميداً، وصلاة على النبي وآله، وفي الوجه الثاني التاريخ واسم الخليفة. وهكذا أيام العباسيين والعبيديين والأمويين.
وأما صنهاجة فلم يتخذوا سكة إلا آخر الأمر، اتخذها منصور صاحب بجاية، ذكر ذلك ابن حماد في تاريخه. ولما جاءت دولة الموحدين كان مما سن لهم المهدي اتخاذ سكة الدرهم مربع الشكل، وأن يرسم في دائرة الدينار شكل مربع في وسطه، ويملأ من أحد الجانبين تهليلاً وتحميداً، ومن الجانب الآخر كتباً في السطور باسمه واسم الخلفاء من بعده، ففعل ذلك الموحدون، وكانت سكتهم على هذا الشكل لهذا العهد. ولقد كان المهدي، فيما ينقل، ينعت قبل ظهوره بصاحب الدرهم المربع، نعته بذلك المتكلمون بالحدثان من قبله، المخبرون في ملاحمهم عن دولته.
وأما أهل المشرق لهذا العهد فسكتهم غير مقدرة، وإنما يتعاملون بالدنانير والدراهم وزناً بالصنجات المقدرة بعدة منها، ولا يطبعون عليها بالسكة نقوش الكلمات بالتهليل والصلاة واسم السلطان كما يفعله أهل المغرب. " ذلك تقدير العزيز العليم " .
ولنختم الكلام في السكة بذكر حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين وبيان حقيقة مقدارهما.
مقدار الدرهم والدينار الشرعيين
وذلك أن الدينار والدرهم مختلفا السكة في المقدار والموازين بالأفاق والأمصار وسائر الأعمال والشرع قد تعرض لذكرهما وعلق كثيراً من الأحكام بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها. فلا بد لهما عنده من حقيقة ومقدار معين في تقدير تجري عليهما أحكامه دون غير الشرعي منهما. فاعلم أن الاجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتامعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقية منه أربعين درهماً، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار، ووزن المثقال من الذهب اثنتنان وسبعون حبة من الشعير. فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبة وخمسا حبة. وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع. فإن الدرهم الجاهلي كان بينهم على أنواع أجودها الطبري، وهو أربعة دوانق، والبغلي وهو ثمانية دوانق، فجعلوا الشرعي بينهما وهو ستة دوانق. فكانوا يوجبون الزكاة في مائة ددرهم بغلية ومائة طبرية خمسة دراهم وسطاً.
وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك، وإجماع الناس بعد عليه كما ذكرناه، ذكر ذلك الخطام في كتاب معالم السنن والماوردي في الأحكام السلطانية، وأنكره المحققون من المتأخرين، لما يلزم عليه أن يكون الدينار والدرهم الشرعيان مجهولين في عهد الصحابة ومن بعدهم، مع تعلق الحقوق الشرعية بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها كما ذكرناه.
والحق أنهما كانا معلومي المقدار في ذلك العصر لجريان الأحكام يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوق. وكان مقدارهما غير مشخص في الخارج، وإنما كان متعارفاً بينهم بالحكم الشرعي على المقدر في مقدارهما وزنتهما. حتى استفحل الإسلام وعظمت الدولة، ودعت الحال إلى تشخيصهما في المقدار والوزن كما هو عند الشرع ليستريحوا من كلفة التقدير. وقارن ذلك أيام عبد الملك فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج، كما هو في الذهن، ونقش عليهما السكة باسمه وتاريخه إثر الشهادتين الإيمانتين، وطرح النقود الجاهلية رأساً حتى خلصت ونقش عليها سكة وتلاشى وجودها. فهذا هو الحق الذي لا محيد عنه.
ومن بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة في الدول على مخالفة المقدار الشرعي في الدينار والدرهم، واختلفت في كل الأقطار والآفاق، ورجع الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية ذهناً كما كان في الصدر الأول، وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم، بمعرفة النسبة التى بينها وبين مقاديرها الشرعية.
وأما وزن الدينار باثنين وسبعين حبة من الشعير الوسط فهو الذي نقله المحققون وعليه الإجماع إلا ابن حزم خالف ذلك، وزعم أن وزنه أربعة وثمانون حبة، نقل ذلك عنه القاضي عبد الحق، ورده المحققون، وعدوه وهماً وغلطاً وهو الصحيح. " والله يحق الحق بكلماته " .
وكذلك تعلم أن الأوقية الشرعية ليست هي المتعارفة بين الناس، لأن المتعارفة مختلفة باختلاف الأقطار، والشرعية متحدة ذهناً لا اختلاف فيها. " والله خلق كل شيء فقدره تقديراً " .
الخاتموأما الخاتم فهو من الخطط السلطانية والوظائف الملوكية. والختم على الرسائل والصكوك معروف للملوك قبل الإسلام وبعده. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى قيصر، فقيل له: إن العجم لا يقبلون كتاباً إلا أن يكون مختوماً، فاتخذ خاتماً من فضة ونقش فيه: " محمد رسول الله " .
قال البخاري: " جعل ثلاث كلمات في ثلاثة أسطر وختم به، وقال: لا ينقش أحد مثله " قال: " وتختم به أبو بكر وعمر وعثمان، ثم سقط من يد عثمان في بئر أريس، وكانت قليلة الماء فلم يدرك قعرها بعد، واغتم عثمان وتطير منه وصنع آخر على مثله.
وفي كيفية نقش الخاتم والختم به وجوه. وذلك أن الخاتم يطلق على الألة التي تجعل في الأصبع، ومنه تختم إذا لبسه. ويطلق على النهاية والتمام، ومنه ختمت الأمر إذا بلغت آخره، وختمت القرآن كذلك، ومنه خاتم النبيين وخاتم الأمر. ويطلق على السداد الذي يسد به الأواني والدنان، ويقال فيه ختام، ومنه قوله تعالى: " ختامه مسك " وقد غلط من فسر هذا بالنهاية والتمام، قال لأن آخر ما يجدونة في شرابهم ريح المسك، وليس المعنى عليه، وإنما هو من الختام، الذي هو السداد، لأن الخمر يجعل لها في الدن سداد الطين أو القار يحفظها ويطيب عرفها وذوقها، فبولغ في وصف خمر الجنة بأن سدادها من المسك، وهو أطيب عرفاً وذوقاً من القار والطين المعهودين في الدنيا.
فإذا صح إطلاق الخاتم على هذه كلها صح إطلاقه على أثرها الناشىء عنها.
وذلك أن الخاتم إذا نقشت به كلمات أو أشكال ثم غمس في مذاق من الطين أو مداد، ووضع على صفح القرطاس بقي أكثر الكلمات في ذلك الصفح. وكذلك إذا طبع به على جسم لين كالشمع، فإنه يبقى نقش ذلك المكتوب مرتسماً فيه. وإذا كانت كلمات وارتسمت فقد يقرأ من الجهة اليسرى إذا كان النقش على الاستقامة من اليمنى، وقد يقرأ من الجهة اليمنى إذا كان النقش من الجهة اليسرى، لأن الختم يقلب جهة الخط في الصفح كما كان في النقش من يمين أو يسار. فيحتمل أن يكون الختم بهذا الخاتم بغمسه في المداد أو الطين، ووضعه على الصفح فتنتقش الكلمات فيه، ويكون هذا من معنى النهاية والتمام بمعنى صحة ذلك المكتوب ونفوذه، كأن الكتاب إنما يتم العمل به بهذه العلامات، وهو من دونها ملغى ليس بتمام. وقد يكون هذا الختم بالخط آخر الكتاب أو أوله بكلمات منتظمة من تحميد أو تسبيح، أو باسم السلطان أو الأمير أو صاحب الكتاب كائناً من كان، أو شيء من نعوته، يكون ذلك الخط علامة على صحة الكتاب ونفوذه، ويسمى ذلك في المتعارف علامة، ويسمى ختماً تشبيهاً له بأثر الخاتم الأصفي في النقش، ومن هذا خاتم القاضي الذي يبعث به للخصوم، أي علامته وخطه الذي ينفذ بهما أحكامه، ومنه خاتم السلطان أو الخليفة أي علامته. قال الرشيد ليحيى بن خالد لما أراد أن يستوزر جعفراً ويستبدل به من الفضل أخيه، فقال لأبيهما يحيى: " يا أبت إني أردت أن أحول الخاتم من يميني إلى شمالي " . فكنى له بالخاتم عن الوزارة، لما كانت العلامة على الرسائل والصكوك من وظائف الوزارة لعهدهم. ويشهد لصحة هذا الإطلاق ما نقله الطبري أن معاوية أرسل إلى الحسن عند مراودته إياه في الصلح صحيفة بيضاء ختم على أسفلها، وكتب إليه أن اشترط في هذه الصحيفة التي ختمت أسفلها ما شئت فهو لك. ومعنى الختم هنا علامة في آخر الصحيفة بخطه أو غيره. ويحتمل أن يختم به في جسم لين فتنتقش فيه حروفه، ويجعل على موضع الحزم من الكتاب إذا حزم وعلى المودوعات وهو من السداد كما مر. وهو في الوجهين آثار الخاتم، فيطلق عليه خاتم.
وأول من أطلق الختم على الكتاب، أي العلامة معاوية، لأنه أمر لعمر بن الزبير عند زياد بالكوفة بمائة ألف، ففتح الكتاب وصير المائة مائتين ورفع زياد حسابه، فأنكرها معاوية، وطلب بها عمر وحبسه حتى قضاها عنه أخوه عبد الله. واتخذ معاوية عند ذلك ديوان الخاتم ذكره الطبري. وقال آخرون: وحزم الكتب ولم تكن تحزم أي جعل لها السداد. وديوان الختم عبارة عن الكتاب القائمين على إنفاذ كتب السلطان والختم عليها إما بالعلامة أو بالحزم. وقد يطلق الديوان على مكان جلوس هؤلاء الكتاب كما ذكرناه في ديوان الأعمال.
والحزم للكتب يكون إما بمس الورق كما في عرف كتاب المغرب، وأما بلصق رأس الصحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب كما في عرف أهل المشرق. وقد يجعل على مكان الدس أو الإلصاق علامة يؤمن معها من فتحه والاطلاع على ما فيه. فأهل المغرب يجعلون على مكان الدس قطعة من الشمع ويختمون عليها بخاتم نقشت فيه علامة لذلك، فيرتسم النقش في الشمع. وكان في المشرق في الدول القديمة يختم على مكان اللصق بخاتم منقوش أيضاً قد غمس في مذاق من الطين معد لذلك، صبغه أحمر فيرتسم ذلك النقش عليه. وكان هذا الطين في الدولة العباسية يعرف بطين الختم، وكان يجلب من سيراف، فيظهر أنه مخصوص بها.
فهذا الخاتم الذي هو العلامة المكتوبة أو النقش للسداد، والحزم للكتب خاص بديوان الرسائل. وكان ذلك للوزير في الدولة العباسية. ثم اختلف العرف وصار لمن إليه الترسيل وديوان الكتاب في الدولة. ثم صاروا في دول المغرب يغدون من علامات الملك وشاراته الخاتم للأصبع، فيستجيدون صوغه من الذهب ويرصعونه بالفصوص من الياقوت والفيروزج والزمرد، ويلبسه السلطان شارة في عرفهم، كما كانت البردة والقضيب في الدولة العباسية والمظلة في الدولة العبيدية. والله مصرف الأمور بحكمه.
الطرازمن أبهة الملك والسلطان ومذاهب الدول أن ترسم أسماوهم أو علامات تختص بهم في طراز أثوابهم المعدة للباسهم، من الحرير أو الديباج أو الإبريسم، تعتبر كتابة خطها في نسج الثوب ألحاماً وأسداء بخيط الذهب، أو ما يخالف لون الثوب من الخيوط الملونة من غير الذهب، على ما يحكمه الصناع في تقدير ذلك ووضعه في صناعة نسجهم، فتصير الثياب الملوكية معلمة بذلك الطراز قصد التنويه بلابسها من السلطان فمن دونه، أو التنويه بمن يختصه السلطان بملبوسه إذا قصد تشريفه بذلك أو ولايته لوظيفة من وظائف دولته.
وكان ملوك العجم من قبل الإسلام يجعلون ذلك الطراز بصور الملوك وأشكالهم، أو أشكال وصور معينة لذلك. ثم اعتاض ملوك الإسلام عن ذلك بكتب أسمائهم مع كلمات أخرى تجري مجرى الفأل أو السجلات. وكان ذلك في الدولتين من أبهة الأمور وأفخم الأحوال. وكانت الدور المعدة لنسج أثوابهم في قصورهم تسمى دور الطراز لذلك. وكان القائم على النظر فيها يسمى صاحب الطراز، ينظر في أمور الصباغ والآلة والحاكة فيها، وإجراء أرزاقهم وتسهيل آلالتهم ومشارفة أعمالهم. وكانوا يقلدون ذلك لخواص دولتهم وثقات مواليهم. وكذلك كان الحال في دولة بني أمية بالأندلس، والطوائف من بعدهم، وفي دولة العبيديين بمصر، ومن كان على عهدهم من ملوك العجم بالمشرق. ثم لما ضاق نطاق الدول عن الترف والتفنن فيه لضيق نطاقها في الاستيلاء، وتعددت الدول، تعطلت هذه الوظيفة والولاية عليها من أكثر الدول بالجملة.
ولما جاءت دولة الموحدين بالمغرب بعد بني أمية أول المائة السادسة، لم يأخذوا بذلك أول دولتهم، لما كانوا عليه من منازع الديانة والسذاجة التي لقنوها عن إمامهم محمد بن تومرت المهدي، وكانوا يتوزعون عن لباس الحرير والذهب، فسقطت هذه الوظيفة من دولتهم، واستدرك منها أعقابهم آخر الدولة طرفاً لم يكن بتلك النباهة. وأما لهذا العهد فأدركنا بالمغرب، في الدولة المرينية لعنفوانها وشموخها رسماً جليلاً لقنوه من دولة ابن الأحمر معاصرهم بالأندلس، واتبع هو في ذلك ملوك الطوائف، فأتى منه بلمحة شاهدة بالأثر.
وأما دولة الترك بمصر والشام لهذا العهد ففيها من الطراز تحرير آخر على مقدار ملكهم وعمران بلادهم إلا أن ذلك لا يصنع في دورهم وقصورهم وليست من وظائف دولتهم، وإنما ينسج ما تطلبه الدولة من ذلك عند صناعه من الحرير ومن الذهب الخالص، ويسمونه المزركش لفظة أعجمية ويرسم اسم السلطان أو الأمير عليه ويعده الصناع لهم فيما يعدونه للدولة من طرف الصناعة اللائقة بها. والله مقدر الليل والنهار، والله خير الوارثين.
الفساطيط والسياج
اعلم أن من شارات الملك وترفه اتخاذ الأخبية والفساطيط والفازات من ثياب الكتان والصوف والقطن بجدل الكتان والقطن، فيباهى بها في الأسفار وتنوع منها الألوان ما بين كبير وصغير على نسبة الدولة في الثروة واليسار، وإنما يكون الأمر في أول الدولة في بيوتهم التي جرت عادتهم باتخاذها قبل الملك. وكان العرب لعهد الخلفاء الأولين من بني أمية إنما يسكنون بيوتهم التي كانت لهم خياماً من الوبر والصوف. ولم تزل العرب لذلك العهد بادين إلا الأقل منهم. فكانت أسفارهم لغزواتهم، وحروبهم بظعونهم وسائر حللهم وأحيائهم من الأهل والولد كما هو شأن العرب لهذا العهد. وكانت عساكرهم لذلك كثيرة الحلل، بعيدة ما بين المنازل، متفرقة الأحياء، يغيب كل واحد منها عن نظر صاحبه في الأخرى كشأن العرب. ولذلك كان عبد الملك يحتاج إلى ساقة تحشد الناس على آثره أن يقيموا إذا ظعن. ونقل أنه استعمل في ذلك الحجاج حين أشار به روح بن زنباع وقصتها في إحراق فساطيط روح وخيامه لأول ولايته حين وجدهم مقيمين في يوم رحيل عبد الملك قصة مشهورة. ومن هذه الولاية تعرف رتبة الحجاج بين العرب، فإنه لا يتولى إرادتهم على الظعن إلا من يأمن بوادر السفهاء من أحيائهم، بما له من العصبية الحائلة دون ذلك، ولذلك اختصه عبد الملك بهذه الرتبة ثقة بغنائه فيها بعصبيته وصرامته.
فلما تفننت الدولة العربية في مذاهب الحضارة والبذخ ونزنوا المدن والأمصار وانتقلوا من سكنى الخيام إلى سكنى القصور، ومن ظهر الخف إلى ظهر الحافر، اتخذوا للسكنى في أسفارهم ثياب الكتان يستعملون منها بيوتاً مختلفة الأشكال مقدرة الأمثال من القوراء والمستطيلة والمربعة ويحتفلون فيها بأبلغ مذاهب الاحتفال والزينة، ويدير الأمير القائد للعساكر على فساطيطه وفازاته من بينهم سياجاً من الكتان يسمى في المغرب بلسان البربر، الذي هو لسان أهله " أفراك بالكاف التي بين الكاف والقاف، ويختص به السلطان بذلك القطر لا يكون لغيره.
وأما في المشرق فيتخذه كل أمير وإن كان دون السلطان. ثم جنحت الدعة بالنساء والولدان إلى المقام بقصورهم ومنازلهم، فخف لذلك ظهرهم وتقاربت الساح بين منازل العسكر، واجتمع الجيش والسلطان في معسكر واحد، يحصره البصر في بسيطة زهواً أنيقاً لاختلاف ألوانه. واستمر الحال على ذلك في مذاهب الدول في بذخها وترفها.
وكذا كانت دولة الموحدين وزناتة التي أظلتنا. كان سفرهم أول أمرهم في بيوت سكناهم قبل الملك من الخيام والقياطن، حتى إذا أخذت الدولة في مذاهب الترف وسكنى القصور عادوا إلى سكنى الأخبية والفساطيط، وبلغوا من ذلك فوق ما أرادوه وهو من الترف بمكان. إلا أن العساكر به تصير عرضة للبيات لاجتماعهم في مكان واحد تشملهم فيه الصيحة ولخفتهم من الأهل والولد الذين تكون الاستماتة دونهم، فيحتاج في ذلك إلى تحفظ آخر. والله القوى العزيز.
المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبةوهما من الأمور الخلافية ومن شارات الملك الإسلامي، ولم يعرف في غير دول الإسلام.
فأما البيت المقصورة من المسجد لصلاة السلطان فيتخذ سياجاً على المحراب، فيحوزه وما يليه. فأول من اتخذها معاوية بن أبي سفيان حين طعنه الخارجي، والقصة معروفة، وقيل أول من اتخذها مروان بن الحكم حين طعنه اليماني. ثم اتخذها الخلفاء من بعدهما وصارت سنة في تمييز السلطان عن الناس في الصلاة. وهي إنما تحدث عند حصول الترف في الدول والاستفحال شأن أحوال الأبهة كلها. وما زال الشأن ذلك في الدول الإسلامية كلها. وعند افتراق الدولة العباسية وتعدد الدول بالمشرق، وكذا بالأندلس عند انقراض الدولة الأموية وتعدد ملوك الطوائف. وأما المغرب فكان بنو الأغلب يتخذونها بالقيروان ثم الخلفاء العبيديون، ثم ولاتهم على المغرب من صنهاجة، بنو باديس بفاس، وبنو حماد بالقلعة. ثم ملك الموحدون سائر المغرب والأندلس، ومحوا ذلك الرسم على طريقة البداوة التي كانت شعارهم. ولما استفحلت الدولة وأخذت بحظها من الترف، وجاء أبو يعقوب المنصوز ثالث ملوكهم فاتخذ هذه المقصورة، وبقيت من بعده سنة لملوك المغرب والأندلس. وهكذا كان الشأن في سائر الدول. سنة الله في عباده.
وأما الدعاء على المنابر في الخطبة فكان الشأن أولاً عند الخلفاء ولاية الصلاة بأنفسهم. فكانوا يدعون لذلك بعد الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والرضا عن أصحابه. وأول من اتخذ المنبر عمرو بن العاص لما بنى جامعه بمصر. وأول من دعا للخليفة على المنبر ابن عباس، دعا لعلي رضي الله عنهما في خطبته وهو بالبصرة عامل له عليها، قال: اللهم انصر علياً على الحق. واتصل العمل على ذلك فيما بعد. وبعد أخذ عمرو بن العاص المنبر بلغ عمر بن الخطاب ذلك، فكتب إليه عمر بن الخطاب: " أما مد، فقد بلغني أنك اتخذت منبراً ترقى به على رقاب المسلمين، أو ما يكفيك أن تكون قائماً والمسلمون تحت عقبك؟! فعزمت عليك إلا ما كسرته. فلما حدثت الأبهة، وحدث في الخلفاء المانع من الخطبة والصلاة استنابوا فيهما. فكان الخطيب يشيد بذكر الخليفة على المنبر تنويهاً باسمه ودعاء له بما جعل الله مصلحة العالم فيه، ولأن تلك ساعة مظنة للإجابة، ولما ثبت عن السلف في قولهم: من كانت له دعوة صالحة ليضعها في السلطان. وكان الخليفة يفرد بذلك.
فلما جاء الحجر والاستبداد صار المتغلبون على الدول كثيراً ما يشاركون الخليفة بذذلك، ويشاد باسمهم عقب اسمه. وذهب ذلك بذهاب تلك الدول، وصار الأمر إلى ختصاص السلطان بالدعاء له على المنبر دون من سواه، وحظر أن يشاركه فيه أحد يسمو إليه.
وكثيراً ما يغفل الماهدون من أهل الدول هذا الرسم عندما تكون الدولة في أسلوب الغضاضة ومناحي البداوة في التغافل والخشونة، ويقنعون بالدعاء على الإبهام والإجمال لمن ولي أمور المسلمين. ويسمون مثل هذه الخطبة إذا كانت على هذا المنحى عباسية، يعنون بذلك أن الدعاء على الإجمال إنما يتناول العباسي تقليداً في ذلك لما سلف من الأمر، ولا يحفلون بما وراء ذلك من تعيينه والتصريح باسمه. يحكى أن يغمراسن بن زيان، ماهد دولة بني عبد الواد لما غلبه الأمير أبو زكريا يحيى بن أبي حفص على تلمسان، ثم بدا له في إعادة الأمر إليه على شروط شرطها، كان فيها ذكر اسمه على منابر عمله، فقال يغمراسن: تلك أعوادهم يذكرون عليها من شاؤوا. وكذلك يعقوب بن عبد الحق ماهد دولة بني مرين، حضره رسول المستنصر الخليفة بتونس من بني أبي حفص وثالث ملوكهم، وتخلف بعض أيامه عن شهود الجمعة، فقيل له لم يحضر هذا الرسول كراهية لخلو الخطبة من ذكر سلطانه، فأذن في الدعاء له، وكان ذلك سبباً لأخذهم بدعوته. وهكذا شأن الدول في بدايتها وتمكنها في الغضاضة والبداوة. فإذا انتبهت عيون سياستهم، ونظروا في أعطاف ملكهم واستتموا شيات الحضارة ومعاني البذخ والأبهة، انتحلوا جميع هذه السمات وتفننوا فيها، وتجاروا إلى غايتها، وأنفوا من المشاركة فيها، وجزعوا من افتقادها وخلو دولتهم من آثارها. والعالم بستان. والله على كل شيء رقيب.
الفصل السابع والثلاثون
في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها
اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله. وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض، ويتعصب لكل منها أهل عصبيته. فإذا تذامروا لذلك وتوافقت الطائفتان إحداهما تطلب الإنتقام والأخرى تدافع، كانت الحرب وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل.وسبب هذا الإنتقام في الأكثر: إما غيرة ومنافسة، وإما عدوان ة وإما غضب لله ولدينه ث وإما غضب للملك وسعي في تمهيده. فالأول أكثر ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة. والثاني، وهو العدوان، أكثر ما يكون من الأمم الوحشية الساكنين بالقفر كالعرب والترك والتركمان والأكراد وأشباههم، لأنهم جعلوا أرزاقهم في رماحهم، ومعاشهم فيما بأيدي غيرهم، ومن دافعهم عن متاعه آذنوه بالحرب، ولا بغية لهم فيما وراء ذلك من رتبة ولا ملك، وإنما همهم ونصب أعينهم غلب الناس على ما في أيديهم. والثالث هو المسمى في الشريعة بالجهاد. والرابع هو حروب الدول مع الخارجين عليها والمانعين لطاعتها، فهذه أربعة أصناف من الحروب: الصنفان الأولان منها حروب بغي وفتنة، والصنفان الأخيران حروب جهاد وعدل، وصفة الحروب الواقعة بين الخليقة منذ أول وجودهم على نوعين: نوع بالزحف صفوفاً، ونوع بالكر والفر. أما الذي بالزحف فهو قتال العجم كلهم على تعاقب أجيالهم.
وأما الذي بالكر والفر فهو قتال العرب والبربر من أهل المغرب.
وقتال الزحف أوثق وأشد من قتال الكر والفر. وذلك لأن قتال الزحف ترتب فيه الصفوف، وتسوى كما تسوى القداح أو صفوف الصلاة، ويمشون بصفوفهم إلى العدو قدماً. فلذلك تكون أثبت عند المصارع وأصدق في القتال وأرهب للعدو، لأنه كالحائط الممتد والقصر المشيد، لا يطمع في إزالته.
وفي التنزيل: " إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص " أي يشد بعضهم بعضاً بالثبات. وفي الحديث الكريم: " المؤمن للمؤمن كالبنيان يسد بعضه بعضاً. ومن هنا يظهر لك حكمة إيجاب الثبات وتحريم التولي في الزحف، فإن المقصود من الصف في القتال حفظ النظام كما قلناه، فمن ولى العدو ظهره فقد أخل بالمصاف، وباء بإثم الهزيمة إن وقعت وصار كأنه جرها على المسلمين، وأمكن منهم عدوهم، فعظم الذنب لعموم المفسدة، وتعديها إلى الدين بخرق سياجه، فغد من الكبائر. ويظهر من هذه الأدلة أن قتال الزحف أشد عند الشارع.
وأما قتال الكر والفر فليس فيه من الشدة والأمن من الهزيمة ما في قتال الزحف.
إلا أنهم قد يتخذون وراءهم في القتال مصافاً ثابتاً يلجأون إليه في الكر والفر، ويقوم لهم مقام قتال الزحف كما نذكره بعد.
ثم إن الدول القديمة الكثيرة الجنود المتسعة الممالك كانوا يقسمون الجيوش والعساكر أقساماً، يسمونها كراديس، ويسوون في كل كردوس صفوفه. وسبب ذلك أنه لما كثرت جنودهم الكثرة البالغة، وحشدوا من قاصية النواحي، استدعى ذلك أن يجهل بعضهم بعضاً إذا اختلطوا في مجال الحرب واعتوروا مع عدوهم الطعن والضرب، فيخشى من تدافعهم فيما بينهم لأجل النكراء وجهل بعضهم ببعض، فلدلك كانوا يقسمون العساكر جموعاً ويضمون المتعارفين بعضهم لبعض، ويرتبونها قريباً من الترتيب الطبيعي في الجهات الأربع. ورئيس العساكر كلها من سلطان أو قائد في القلب. ويسمون هذا الترتيب التعبئة، وهو مذكور في أخبار فارس والروم والدولتين صدر الإسلام. فيجعلون بين يدي الملك عسكراً منفرداً بصفوفه متميزاً بقائده ورايته وشعاره، ويسمونه المقدمة، ثم عسكراً آخر من ناحية اليمين عن موقف الملك وعلى سمته يسمون الميمنة، ثم عسكراً آخر من ناحية الشمال كذلك يسمون الميسرة، ثم عسكراً آخر من وراء العسكر يسمونه الساقة، ويقف الملك وأصحابه في الوسط بين هذه الأربع، ويسمون موقفه القلب. فإذا تم لهم هذا الترتيب المحكم، إما في مدى واحد للبصر أو على مسافة بعيدة، أكثرها اليوم واليومان بين كل عسكرين منها، أو كيفما أعطاه حال العساكر في القلة والكثرة، فحينئذ يكون الزحف من بعد هذه التعبئة.
وانظر ذلك في أخبار الفتوحات وأخبار الدولتين بالمشرق، وكيف كانت العساكر لعهد عبد الملك تتخفف عن رحيله لبعد المدى في التعبئة، فاحتيج لمن يسوقها من خلفه وعين لذلك الحجاج بن يوسف كما أشرنا إليه، وكما هو معروف في أخباره. وكان في الدولة الأموية بالأندلس أيضاً كثير منه وهو مجهول فيما لدينا، لأنا إنما أدركنا دولاً قليلة العساكر، لا تنتهي في مجال الحرب إلى التناكر، بل أكثر الجيوش من الطائفتين معاً يجمعهم لدينا حلة أو مدينة، ويعرف كل واحد منهم قرنه ويناديه في حومة الحرب باسمه ولقبه، فاستغني عن تلك التعبئة.
ضرب المصاف وراء العسكرومن مذاهب أهل الكر والفر في الحروب ضرب المصاف وراء عسكرهم من الجمادات والحيوانات العجم، فيتخذونها ملجأ للخيالة في كرهم وفرهم، يطلبون به ثبات المقاتلة ليكون أدوم للحرب وأقرب إلى الغلب. وقد يفعله أهل الزحف أيضاً ليزيدهم ثباتاً وشدة.
فقد كان الفرس وهم أهل الزحف، يتخذون الفيلة في الحروب ويحملون عليها أبراجاً من الخشب أمثال الصروح، مشحونة بالمقاتلة والسلاح والرايات، ويصفونها وراءهم في حومة الحرب كأنها حصون، فتقوى بذلك نفوسهم ويزداد وثوقهم.
وانظر ما وقع من ذلك في القادسية، وأن فارس في اليوم الثالث اشتدوا بها على المسلمين حتى اشتدت رجالات من العرب فخالطوهم وبعجوها بالسيوف على خراطيمها، فنفرت ونكصت على أعقابها إلى مرابطها بالمدائن، فجفا معسكر فارس لذلك وانهزموا في اليوم الرابع.
وأما الروم وملوك القوط بالأندلس وأكثر العجم، فكانوا يتخذون لذلك الأسرة ينصبون للملك سريره في حومة الحرب، ويحف به من خدمه وحاشيته وجنوده من هو زعيم بالاستماتة دونه، وترفع الرايات في أركان السرير، ويحدق به سياج آخر من الرماة والرجالة، فيعظم هيكل السرير ويصير فئة للمقاتلة وملجأ للكر والفر. وجعل ذلك الفرس أيام القادسية، وكان رستم جالساً على سرير نصبه لجلوسه، حتى إختلفت صفوف فارس وخالطه العرب في سريره ذلك، فتحول عنه إلى الفرات وقتل.
وأما أهل الكر والفر من العرب وأكثر الأمم البدوية الرحالة فيصفون لذلك إبلهم والظهر الذي يحمل ظعائنهم فيكون فئة لهم، ويسمونها المجبوذة، وليس أمة من الأمم إلا وهي تفعل ذلك في حروبها، وتراه أوثق في الجولة، وآمن من الغرة والهزيمة. وهو أمر مشاهد.
وقد أغفلته الدول لعهدنا بالجملة، واعتاضوا عنه بالظهر الحامل للأثقال والفساطيط يجعلونها ساقة من خلفهم، ولا تغني غناء الفيلة والإبل. فصارت العساكر بذلك عرضة للهزائم، ومستشعرة للفرار في المواقف.
وكان الحرب أول الإسلام كله زحفاً. وكان العرب إنما يعرفون الكر والفر. لكن حملهم على ذلك أول الإسلام أمران: أحدهما أن عدوهم كانوا يقاتلون زحفاً فيضطرون إلى مقاتلتهم بمثل قتالهم، الثاني: أنهم كانوا مستميتين في جهادهم لما رغبوا فيه من الصبر، ولما رسخ فيهم من الإيمان، والزحف إلى الاستماتة أقرب.
وأول من أبطل الصف في الحروب وصار إلى التعبئة كراديس مروان بن الحكم في قتال الضحاك الخارجي والحبيري بعده. قال الطبري: لما ذكر قتال الحبيري: فولى الخواربخ عليهم شيبان بن عبد العزيز اليشكري ويلقب أبا الذلفاء، وقاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس، وأبطل الصف من يومئذ انتهى. فتنوسي قتال الزحف بإبطال الصف، ثم تنوسي الصف وراء المقاتلة بما داخل الدول من الترف. وذلك إنها حينما كانت بدوية وسكناهم الخيام كانوا يستكثرون من الإبل وسكنى النساء والولدان معهم في الأحياء. فلما حصلوا على ترف الملك وألفوا سكنى القصور والحواضر وتركوا شأن البادية والقفر نسوا لذلك عهد الأبل والظعائن، وصعب عليهم اتخاذها، فخلفوا النساء في الأسفار وحملهم الملك والترف على اتخاذ الفساطيط والأخبية، فاقتصروا على الظهر الحامل للأثقال والأبنية وكان ذلك صفتهم في الحرب. ولايغني كل الغناء لأنه لا يدعو إلى الاستماتة كما يدعو إليها الأهل والمال. فيخف الصبر من أجل ذلك وتصرفهم الهيعات وتخرم صفوفهم.
فصل: ولما ذكرناه من ضرب المصاف وراء العساكر وتأكده في قتال الكر والفر، صار ملوك المغرب يتخذون طائفة من الأفرنج في جندهم، واختصوا بذلك لأن قتال أهل وطنهم كله بالكر والفر. والسلطان يتأكد في حقه ضرب المصاف ليكون ردءاً للمقاتلة أمامه، فلا بد وأن يكون أهك ذلك الصف من قوم متعودين للثبات في الزحف، وإلا أجفلوا على طريقة أهل الكر والفر، فانهزم السلطان والعساكر بإجفالهم، فاحتاج الملوك بالمغرب أن يتخذوا جنداً من هذه الأمة المتعودة الثبات في الزحف وهم الأفرنج، ويرتبون مصافهم المحدق بهم منها، هذا على ما فيه من الأستعانة بأهل الكفر. وإنما استخفوا ذلك للضرورة التي أريناكها من تخوف الأجفال على مصاف السلطان والإفرنج لا يعرفون غير الثبات في ذلك، لأن عادتهم في القتال الزحف، فكانوا أقوم بذلك من غيرهم. مع أن الملوك في المغرب إنما يفعلون ذلك عند الحرب مع أمم العرب والبربر، وقتالهم على الطاعة، وأما في الجهاد فلا يستعينون بهم حذراً من ممالأتهم على المسلمين. هذا هو الواقع بالمغرب لهذا العهد، وقد أبدينا سببه.، الله بكل شيء عليم.
فصل: وبلغنا أن أمم الترك لهذا العهد قتالهم مناضلة بالسهام، وأن تعبئة الحرب عندهم بالمصاف، وأنهم يقسمون بثلاثة صفوف، يضربون صفاً وراء صف، ويترجلون عن خيولهم، ويفرغون سهامهم بين أيديهم، ثم يتناضلون جلوساً، وكل صف ردء للذي أمامه أن يكبسهم العدو، إلى أن يتهيأ النصر لإحدى الطائفتين على الأخرى. وهي تعبئة محكمة غريبة.
فصل: وكان من مذاهب الأول في حروبهم حفر الخنادق على معسكرهم عندما يتقاربون للزحف، حذراً من معرة البيات والهجوم على العسكر بالليل، لما في ظلمته ووحشته من مضاعفة الخوف، فيلوذ الجيش بالفرار وتجد النفوس في الظلمة ستراً من عاره، فإذا تساووا في ذلك أرجف العسكر ووقعت الهزيمة. فكانوا لذلك يحتفرون الخنادق على معسكرهم إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم، ويديرون الحفائر نطاقاً عليهم من جميع جهاتهم، حرصاً أن يخالطهم العدو بالبيات، فيتخاذلوا. وكانت للدول في أمثال هذا قوة وعليه اقتدار باحتشاد الرجال، وجمع الأيدي عليه في كل منزل من منازلهم، بما كانوا عليه من وفور العمران وضخامة الملك. فلما خرب العمران وتبعه ضعف الدول وقلة الجنود وعدم الفعلة نسي هذا الشان جملة كأنه يكن. والله خير القادرين.
وصية علي رضي الله عنهوتحريضه لأصحابه يوم صفين: وانظر وصية علي رضي الله عنه وتحريضه لأصحابه يوم صفين تجد كثيراً من علم الحرب ولم يكن أحد أبصر بها منه.
قال في كلام له: " فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص وقدموا الدارع وأخروا الحاسر. وعضوا على الأضراس، فإنه أنبى للسيوف عن الهام. والتووا على أطراف الرماح، فإنه أصون للأسنة. وغضوا الأبصار، فإنه أربط للجأش وأسكن للقلوب. واخفتوا الأصوات، فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقار. وأقيموا راياتكم، فلا تميلوها ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم. واستعينوا بالصدق والصبر، فإنه بقدر الصبر ينزل النصر " .
وقال الأشتر يومئذ يحرض الأزد: " عضوا على النواجذ من الأضراس، واستقبلوا القوم بهامكم، وشدوا شدة قوم موتورين يثارون بآبائهم وإخوانهم حناقاً على عدوهم، وقد وطنوا على الموت أنفسهم لئلا يسبقوا بوتر، ولا يلحقهم في الدنيا عار.
وقد أشار إلى كثير من ذلك أبو بكر الصيرفي شاعر لمتونة وأهل الأندلس في كلمة يمدح بها تاشفين بن علي بن يوسف، ويصف ثباته في حرب شهدها، ويذكره بأمور الحرب في وصايا وتحذيرات تنبهك على معرفة كثير من سياسة الحرب يقول فيها:
يا أيها الملأ الذي يتقنع ... من منكم الملك الهمام الأروع
ومن الذي غدر العدو به دجى ... فانفض كل وهو لا يتزعزع
تمضي الفوارس والطعان يصدها ... عنه ويدمرها الوفاء فترجع
والليل من وضح الترائك إنه ... صبح على هام الجيوش يلمع
أنى فزعتم يا بني صنهاجة ... وإليكم في الروع كان المفزع
إنسان عين لم يصبه منكم ... حضن وقلب أسلمته الأضلع
وصددتم عن تاشفين وإنه ... لعقابه لو شاء فيكم موضع
ما أنتم إلا اسود خفية ... كل لكل كريهة مستطلع
يا تاشفين أقم لجيشك عذره ... بالفيل والعذر الذي لا يدفع
ومنها في سياسة الحرب:
أهديك من أدب السياسة ما به ... كانت ملوك الفرس قبلك تولع
لا إنني أدري بها لكنها ... ذكرى تحض المؤمنين وتنفع
والبس من الحلق المضاعفة التي ... وصى بها صنع الصنائع تبع
والهندواني الرقيق فإنه ... سيان تتبع ظافراً أو تتبع
واركب من الخيل السوابق عدة ... أمضى على حد الدلاص وأقطع
خندق عليك إذا ضربت محلة ... حصناًحصيناً ليس فيه مدفع
والواد لا تعبره وانزل عنده ... بين العدو وبين جيشك يقطع
واجعل مناجزة الجيوش عشية ... ووراءك الصدق الذي هو أمنع
وإذا تضايقت الجيوش بمعرك ... ضنك فأطراف الرماح توسع
واصدمه أول وهلة لا تكترث ... شيئاً فإظهار النكول يضعضع
واجعل من الطلاع أهل شهامة ... للصدق فيهم شيمة لاتخدع
لا تسمع الكذاب جاءك مرجفاً ... لا رأي للكذاب فيما يصنع
قوله: " واصدمة أول وهلة لا تكترث " البيت مخالف لما عليه الناس في أمر الحرب. فقد قال عمر لأبي عبيد بن مسعود الثقفي لما ولاه حرب فارس والعراق فقال له: اسمع وأطع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر، ولا تجيبن مسرعاً حتى تتبين، فإنها الحرب ولا يصلح لها إلا الرجل المكيث الذي يعرف الفرصة والكف.
وقال له في أخرى: " إنه لن يمنعني أن أؤمر سليطا إلا سرعته في الحرب. وفي التسرع في الحرب إلا عن بيان ضياع. والله لولا ذلك لأمرته. لكن الحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث " .
هذا كلام عمر، وهو شاهد بأن التثاقل في الحرب أولى من الخفوف، حتى يتبين حال تلك الحرب. وذلك عكس ما قاله الصيرفي إلا أن يريد أن الصدم بعد البيان فله وجه. والله تعالى أعلم.
ولا وثوق في الحرب بالظفر وإن حصلت أسبابه من العدة والعديد، وإنما الظفر فيها والغلب من قبيل البخت والاتفاق. وبيان ذلك أن أسباب الغلب في الأكثر مجتمعة من أمور ظاهرة وهي الجيوش ووفورها وكمال الأسلحة واستجادتها وكثرة الشجعان وترتيب المصاف، ومنه صدق القتال وما جرى مجرى ذلك، ومن أمور خفية وهي إما من خدع البشر وحيلهم في الإرجاف والتشانيع التي يقع بها التخذيل وفي التقدم إلى الأماكن المرتفعة ليكون الحرب من أعلى فيتوهم المنخفض لذلك، وفي الكمون في الغياض ومطمئن الأرض والتواري بالكدى عن العدو حتى يتداولهم العسكر دفعة، وقد تورطوا، فيتلفتون إلى النجاة، وأمثال ذلك. وأما أن تكون تلك الأسباب الخفية، أموراً سماوية لا قدرة للبشر على اكتسابها تلقى في القلوب، فيستولي الرهب عليهم لأجلها فتختل مراكزهم فتقع الهزيمة. وأكثر ما تقع الهزائم عن هذه الأسباب الخفية لكثرة ما يعتمل لكل واحد من الفريقين فيها حرصاً على الغلب، فلا بد من وقوع التأثير في ذلك لأحدهما ضرورة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: " الحرب خدعة " .
ومن أمثال العرب: " رب حيلة أنفع من قبيلة " . فقد تبين أن وقوع الغلب في الحروب غالباً عن أسباب خفية غير ظاهرة، ووقوع الأشياء عن الأسباب الخفية هو معنى البخت كما تقرر في موضعه. فاعتبره وتفهم من وقوع الغلب عن الأمور السماوية كما شرحناه، معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " نصرت بالرعب مسيرة شهر " ، وما وقع من غلبه للمشركين في حياته بالعدد القليل وغلب المسلمين من بعده كذلك في الفتوحات. فإن الله سبحانه وتعالى تكفل لنبيه بإلقاء الرعب في قلوب الكافرين حتى يستولي على قلوبهم، فينهزموا، معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان الرعب في قلوبهم سبباً للهزائم في الفتوحات الإسلامية كلها، إلا أنه خفي عن العيون.
وقد ذكر الطرطوشي: أن من أسباب الغلب في الحروب أن تفضل عدة الفرسان المشاهير من الشجعان في أحد الجانبين على عدتهم في الجانب الأخر، مثل أن يكون أحد الجانبين فيه عشرة أو عشرون من الشجعان المشاهير وفي الجانب الآخر ثمانية أو ستة عشر، فالجانب الزائد ولو بواحد يكون له الغلب، وأعاد في ذلك وأبدى، وهو راجح إلى الأسباب الظاهرة التي قدمنا، وليس بصحيح. وإنما الصحيح المعتبر في الغلب حال العصبية أن يكون في أحد الجانبين عصبية واحدة جامعة لكلهم، وفي الجانب الآخر عصائب متعددة لأن العصائب إذا كانت متعددة يقع بينها من التخاذل ما يقع في الوحدان المتفرقين الفاقدين للعصبية، إذ تنزل كل عصابة منهم منزلة الواحد، ويكون الجانب الذي عصابته متعددة لا يقاوم الجانب الذي عصبيته واحدة لأجل ذلك فتفهمه. واعلم أنه أصح في الاعتبار مما ذهب إليه الطرطوشي ولم يحمله على ذلك إلا نسيان شأن العصبية في حلته وبلده، وأنهم إنما يردون ذلك الدفاع والحماية والمطالبة إلى الوحدان، والجماعة الناشئة عنهم، لا يعتبرون في ذلك عصبية ولا نسباً. وقد بينا ذلك أول الكتاب مع أن هذا وأمثاله على تقدير صحته إنما هو من الأسباب الظاهرة مثل اتفاق الجيش العدة وصدق القتال وكثرة الأسلحة وما أشبهها، فكيف يجعل ذلك كفيلاً بالغلب. ونحن قد قررنا لك الآن أن شيئاً منها لايعارض الأسباب الخفية من الحيل والخداع ولا الأمور السماوية من الرعب والخذلان الإلهي. فافهمه وتفهم أحوال الكون. والله مقدر الليل والنهار.
فصل: ويلحق بمعنى الغلب في الحروب وأن أسبابه خفية وغير طبيعية حال الشهرة والصيت. فقل أن تصادف موضعها في أحد من طبقات الناس، من الملوك والعلماء والصالحين والمنتحلين للفضائل على العموم، وكثير ممن اشتهر بالشر وهو بخلافه، وكثير ممن تجاوزت عنه الشهرة وهو أحق بها وأهلها. وقد تصادف موضعها وتكون طبقاً على صاحبها. والسبب في ذلك أن الشهرة والصيت إنما هما بالأخبار، والأخبار يدخلها الذهول عن المقاصد عند التناقل، ويدخلها التعصب والتشيع، ويدخلها الأوهام، ويدخلها الجهل بمطابقة الحكايات للأحوال، لخفائها بالتلبيس والتصنع أو لجهل الناقل، ويدخلها التقرب لأصحاب التجلة والمراتب الدنيوية بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك، والنفوس مولعة بحب الثناء، والناس متطاولون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة، وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلها، وأين مطابقة الحق مع هذه كلها؟ فتختل الشهرة عن أسباب خفية من هذه، وتكون غير مطابقة. وكل ما حصل بسبب خفي فهو الذي يعبر عنه بالبخت كما تقرر. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق.
الفصل الثامن والثلاثون
في الجباية وسبب قلتها وكثرتها
اعلم أن الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة، و آخر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملة. والسبب في ذلك أن الدولة: إن كانت على سنن الدين فليست تقتضي إلا المغارم الشرعية من الصدقات والخراج والجزية، وهي قليلة الوزائع، لأن مقدار الزكاة من المال قليل كما علمت، وكذا زكاة الحبوب والماشية، وكذا الجزية والخراج وجميع المغارم الشرعية، وهي حدود لا تتعدى، وإن كانت على سنن التغلب والعصبية فلا بد من البداوة في أولها كما تقدم، والبداوة تقتضي المسامحة والمكارمة وخفض الجناح والتجافي عن أموال الناس، والغفلة عن تحصيل ذلك إلا في النادر، فيقل لذلك مقدار الوظيفة الواحدة، والوزيعة التي تجمع الأموال من مجموعها. وإذا قلت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه، فيكثر الاعتمار ويتزايد محصول الاغتباط بقلة المغرم، وإذا كثر الاعتمار كثرت أعداد تلك الوظائف والوزائع، فكثرت الجباية التي هي جملتها. فإذا استمرت الدولة واتصلت، وتعاقب ملوكها واحداً بعد واحد، واتصفوا بالكيس، وذهب شر البداوة والسذاجة وخلقها من الإغضاء والتجافي، وجاء الملك العضوض والحضارة الداعية إلى الكيس، وتخلق أهل الدولة حينئذ بخلق التحذلق، وتكثرت عوائدهم وحوائجهم بسبب ما انغمسوا فيه من النعيم والترف، فيكثرون الوظائف والوزائع حينئذ على الرعايا والأكرة والفلاحين وسائر أهل المغارم، ويزيدون في كل وظيفة ووزيعة مقداراً عظيماً لتكثر لهم الجباية، ويضعون المكوس على المبايعات وفي الأبواب كما نذكر بعد، ثم تتدرج الزيادات فيها بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد الدولة في الترف وكثرة الحاجات والإنفاق بسببه، حتى تثقل المغارم على الرعايا وتنهضم وتصير عادة مفروضة، لأن تلك الزيادة تدرجت قليلاً قليلاً ولم يشعر أحد بمن زادها على التعيين، ولا من هو واضعها، إنما تثبت على الرعايا كأنها عادة مفروضة. ثم تزيد إلى الخروج عن حد الاعتدال، فتذهب غبطة الرعايا في الاعتمار لذهاب الأمل من نفوسهم بقلة النفع، إذا قابل بين نفعه ومغارمه وبين ثمرته وفائدته، فتنقبض كثير من الأيدي عن الاعتمار جملة، فتنقص جملة الجباية حينئذ بنقصان تلك الوزائع منها. وربما يزيدون في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك النقص في الجباية ويحسبونه جبراً لما نقص، حتى تنتهي كل وظيفة ووزيعة إلى غاية ليس وراءها نفع ولا فائدة، لكثرة الانفاق حينئذ في الاعتمار وكثرة المغارم وعدم وفاء الفائدة المرجوة به. فلا تزال الجملة في نقص ومقدار الوزائع والوظائف في زيادة لما يعتقدونه من جبر الجملة بها، إلى أن ينتقص العمران بذهاب الأمال من الاعتمار، ويعود وبال ذلك على الدولة لأن فائدة الاعتمار، عائدة إليها. وإذا فهمت ذلك علمت أن أقوى الأسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوظائف على المعتمرين ما أمكن، فبذلك تنبسط النفوس إليه لثقتها بإدراك المنفعة فيه. والله سبحانه وتعالى مالك الأمور كلها، " وبيده ملكوت كل شيء " .الفصل التاسع والثلاثون
في ضرب المكوس أواخر الدولة
اعلم أن الدولة تكون في أولها بدوية كما قلنا، فتكون لذلك قليلة الحاجات لعدم الترف وعوائده، فيكون خرجها وإنفاقها قليلاً، فيكون في الجباية حينئذ وفاء بأزيد منها، بل يفضل منها كثير عن حاجاتهم. ثم لا تلبث أن تأخذ بدين الحضارة في الترف وعوائدها، وتجري على نهج الدول السابقة قبلها، فيكثر لذلك خراج أهل الدولة، ويكثر خراج السلطان خصوصاً كثرة بالغة بنفقته في خاصته، وكثرة عطائه، ولا تفي بذلك الجباية. فتحتاج الدولة إلى الزيادة في الجباية لما تحتاج إليه الحامية من العطاء، والسلطان من النفقة، فيزيد في مقدار الوظائف والوزائع أولا كما قلناه، ثم يزيد الخراج والحاجات والتدريج في عوائد الترف وفي العطاء للحامية، ويدرك الدولة الهرم، وتضعف عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال والقاصية، فتقل الجباية وتكثر العوائد، ويكثر بكثرتها أرزاق الجند وعطاؤهم. فيستحدث صاحب الدولة أنواعاً من الجباية يضربها على البيعات، ويفوض لها قدراً معلوماً على الأثمان في الأسواق، وعلى أعيان السلع في أموال المدينة. وهو مع هذا مضطر لذلك بما دعاه إليه ترف الناس من كثرة العطاء مع زيادة الجيوش والحامية. وربما يزيد ذلك في أواخر الدولة زيادة بالغة، فتكسد الأسواق لفساد الأمال، ويؤن ذلك باختلال العمران، ويعود على الدولة، ولا يزال ذلك يتزايد إلى أن تضمحل.
وقد كان وقع منه بأمصار المشرق في أخريات الدولة العباسية والعبيدية كثير، وفرضت المغارم حتى على الحاج في الموسم، وأسقط صلاح الدين أيوب تلك الرسوم جملة وأعاضها بآثار الخير. وكذلك وقع بالأندلس لعهد الطوائف حتى محا رسمه يوسف بن تاشفين أمير المرابطينن. وكذلك وقع بأمصار الجريد بإفريقية لهذا العهد حين استبد بها رؤساؤها. والله تعالى أعلم.
الفصل الأربعون
في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا
مفسدة للجباية اعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها بما قدمناه من الترف وكثرة العوائد والنفقات وقصر الحاصل من جباييها على الوفاء بحاجاتها ونفقاتها، واحتاجت إلى مزيد المال والجباية، فتارة توضع المكوس على بياعات الرعايا وأسواقهم كما قدمنا ذلك في الفصل قبله، وتارة بالزيادة في ألقاب المكوس إن كان قد استحدث من قبل، وتارة بمقاسمة العمال والجباة وامتكاك عظامهم، لما يرون أنهم قد حصلوا على شيء طائل من أموال الجباية، لا يظهره الحسبان، وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان على تسمية الجباية لما يرون التجار والفلاحين يحصلون على الفوائد والغلات مع يسارة أموالهم، وأن الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموال. فيأخذون في اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله في شراء البضائع والتعرض بها لحوالة الأسواق، ويحسبون ذلك من إدرار الجباية: تكثير الفوائد. وهو غلط عظيم وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة.فأولاً مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع، وتيسير أسباب ذلك، فإن الرعايا متكافئون في اليسار متقاربون ومزاحمة بعضهم بعضاً تنتهي إلى غاية موجودهم أو تقرب، وإذا رافقهم السلطان في ذلك وماله أعظم كثيراً منهم، فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته، ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد.
ثم إن السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض له غضاً أو بأيسر ثمن، إذ لا يجد من يناقشه في شرائه فيبخس ثمنه على بائعه.