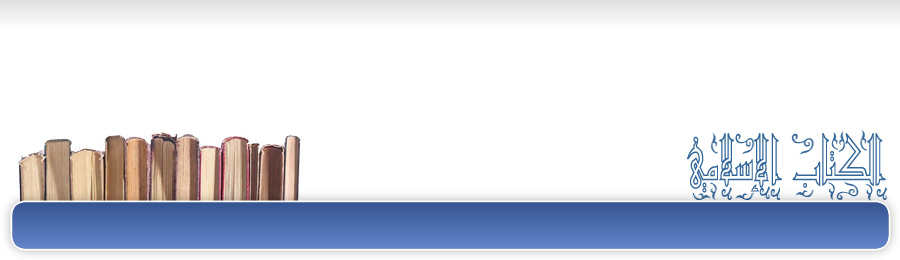كتاب : التبصرة في أصول الفقه
المؤلف : إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي
مسألة 1
الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه وقالت المعتزلة هو إرادة الفعل بالقول ممن هو دونه
لنا هو أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسمعيل ولهذا قال
في الحكاية عن إسمعيل يا أبت افعل ما تؤمر ولم يرد منه ذلك لأنه لو أراد
منه ذلك لوقع منه على أصلهم لأنه لا يجوز أن يريد أمرا ولا يوجد ولما جاز
أن ينهاه على أصلهم لأن الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به ولا يجوز أن
ينهاه عن الحسن
فإن قيل الذي أمر به مقدمات الذبح من الاضجاع وتله للجبين وقد فعل ذلك
قلنا هذا خلاف الظاهر الذي في القرآن إني أرى في المنام أني أذبحك
ولأنه لو كان المأمور به هو المقدمات لم يكن في ذلك بلاء مبين ولا احتاج
فيه إلى صبر وقد قال عز و جل إن هذا لهو البلاء المبين وقال
ستجدني إن شاء الله من الصابرين فدل على أن الأمر تناول جميع ذلك
ولأنه لو كان المأمور به مقدمات الذبح لما احتاج فيه إلى الفداء لأنه قد
فعل ذلك وقد قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم فبطل ما قالوه
فإن قيل فقد فعل الذبح ولكن كلما قطع جزءا التحم
قلنا لو كان هذا صحيحا لكان قد ذكره الله سبحانه وأخبر عنه لأن ذلك من
المعجزات والآيات الباهرة الظاهرة
ولأنه لو كان كما ذكروه لكان لا يفتقر إلى الفداء لأنه قد امتثل الأمر
وأيضا فإن السيد من العرب إذا قال لعبده افعل كذا سموا ذلك أمرا وإن لم
يعلم مراده ولو كان شرط الأمر الإرادة لما أطلقوا عليه هذا الاسم قبل أن
تعلم إرادته
وأيضا أنه لو كان الأمر يقتضي الإرادة لما حسن أن يقول الرجل لعبده أمرتك
بكذا ولم أرده كما لا يجوز أن يقول أردت منك كذا ولم أرده ولما جاز أن
يقول أمرتك بكذا ولم أرده ولم يعد متناقضا دل على أن الأمر لا يقتضي
الإرادة
ولأنه لو كان الأمر يقتضي الإرادة لوجب أن لا يكون أمرا لا مريدا ولما
رأينا من يأمر وليس بمريد وهو المكره دل على أنه لا يقتضي الإرادة
واحتجوا بأن هذه الصفة ترد والمراد بها الأمر كقوله تعالى وأقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة
وترد والمراد بها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم
وترد والمراد بها التكوين كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين
وترد والمراد بها التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله
وإنما ينفصل الأمر بها عما ليس بأمر بالإرادة فدل على أن الإرادة شرط في
كون الصيغة أمرا
الجواب أنا لا نسلم أن الأمر يميز عما ليس بأمر بالإرادة وإنما يتميز
بالاستدعاء فقوله تعالى وأقيموا الصلاة استدعاء فكان أمرا وسائر الصيغ
الأخر لم تكن استدعاء فلم تكن أمرا وإذا جاز أن يكون الأمر يتميز بما
ذكرناه بطل احتجاجهم
قالوا لو لم يكن من شرطه الإرادة لوجب أن يصح الأمر من البهيمة ولما لم
يصح منها دل على أنه إنما لم يصح لعدم الإرادة
قلنا لا نسلم هذا بل أيضا إنما لم يصح لعدم القول ومن شرط الأمر
الاستدعاء بالقول ممن هو دونه ولهذا نقول إن المجنون إذا قال
لمن هو دونه افعل كذا كان ذلك أمرا وإن لم تكن له إرادة
قالوا ولأن العرب لا تفرق بين قولهم أريد منك كذا وبين قولهم افعل كذا
قلنا لا نسلم هذا أيضا بل قوله أريد إخبار عن مراده من غير استدعاء وقوله
افعل كذا استدعاء ألا ترى أنه يدخله الصدق والكذب في قوله أريد ولا يدخل
ذلك في قوله افعل
ولأنه لا يصح أن يقول أريد منك كذا وليس أريده ويصح أن يقول افعل كذا وليس
أريده فدل على أن مقتضى أحدهما غير مقتضى الآخر
واحتجوا بأن النهي إنما كان نهيا لكراهية المنهي عنه فكذلك يجب أن يكون
الأمر أمرا لإرادة المأمور به
قلنا لا نسلم بل النهي إنما كان نهيا لاستدعاء الترك بالقول ممن هو دونه
لا فرق بينه وبين الأمر
مسألة 2
للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهو قول الرجل لمن هو دونه افعلوقالت الأشعرية ليس للأمر صيغة وقوله افعل لا يدل على الأمر إلا بقرينة
لنا هو أن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه عاقبه على ذلك ووبخه عليه واستحسن عقلاء العرب توبيخه وعقوبته ولو لم تكن هذه الصيغة موضوعة للاستدعاء لما حسن عقوبة هذا العبد على تركه الإسقاء
فإن قيل إنما استحق العبد العقوبة لأن المراد بقرينة اقترنت
باللفظ من شاهد الحال دلت على مراد المولى
قلنا لم توجد هناك قرينة ولا شيء سوى هذه الصيغة فدل على أن العقوبة تعلقت
بمخالفتها
ويدل عليه أيضا هو أن أهل العلم باللسان قسموا الكلام أقساما فقالوا أمر
ونهي وخبر واستخبار فالأمر قولهم افعل والنهي قولهم لا تفعل والخبر زيد في
الدار والاستخبار أزيد في الدار ولم يشرطوا في إثبات الأمر قرينة تدل على
كونه أراد فدل على أن الصيغة بمجردها أمر
فإن قيل فلم يشرطوا أيضا أن تكون هذه الصيغة من الأعلى للأدنى ولا خلاف أن
ذلك شرط في كونه أمرا
قلنا قد بينوا ذلك فإنهم سموا هذا الخطاب من الأدني للأعلى مسألة وطلبا
وذكروا ذلك في أقسام الكلام أيضا فعلمنا أن الرتبة شرط وأما القرينة في
كون الصيغة موضوعة للاستدعاء فما ذكرها أحد فبطل اعتبارها
ولأن قوله افعل متصرف من قوله فعلت والمتصرف من كل فعل لا يدل
إلا على ما يدل عليه الفعل ثم ثبت أن قوله فعلت يقتضي وجود الفعل فوجب أن
يكون قوله افعل يقتضي إيجاد الفعل
احتجوا بأن هذه الصيغة ترد والمراد بها الأمر كما قلتم وترد والمراد بها
التهديد وترد والمراد بها التعجيز وترد والمراد بها التكوين على ما مضى في
المسألة قبلها وليس حمله على بعض هذه الأحوال بأولى من بعض فوجب التوقف
فيها كما يتوقف في الأسماء المشتركة مثل اللون والعين وغيرها
والجواب أن هذه الصيغة بمجردها موضوعة للاستدعاء وإنما تحمل على ما عداها
بقرينة من شاهد الحال وغيره وتفارق اللون والعين فإن تلك الأشياء لم توضع
لشيء معين ولهذا لو أمر عبده أن يصبغ له الثوب بلون لم يستحق الذم بأي صبغ
صبغه ولو قال لعبده اسقني ماء استحق الذم بترك الإسقاء ولو كان قوله اسقني
مشتركا بين الفعل والترك كاشتراك اللون بين السواد والبياض لما استحق الذم
والتوبيخ بتركه
ولأن أهل اللغة لم يجعلوا اللون لشيء بعينه بل جعلوا ذلك اسما للون غير
معين وعولوا في التعيين على الوصف فقالوا لون أحمر ولون أصفر ولون أسود
وليس كذلك ههنا
فإن أهل اللغة والنحو جعلوا قوله افعل للاستدعاء ووضعوا للترك لفظا آخر
فافترقا
قالوا إثبات الصيغة للأمر لا يخلو إما أن يكون بالعقل ولا مجال له فيه
أو بالنقل ولا يخلو
إما أن يكون آحادا فلا يقبل في أصل من الأصول
أو متواترا ولا أصل له لأنه لو كان لعلمناه كما علمتم ولما لم يعلم دل على
أنه لا أصل له فلا معنى لإثبات الصيغة
قلنا هذا يقلب عليكم في إثبات الاشتراك في قوله افعل فإنه لا يخلو إما أن
يكون بالعقل ولا مجال له فيه أو بالنقل ولا يجوز أن يكون أحادا لأن ذلك
إثبات أصل فلا يجوز بخبر الواحد أو بالتواتر ولا أصل له فلا معنى لدعوى
الاشتراك
وعلى أنا نقلنا ذلك من طريقين
أحدهما إجماع عقلاء العرب وأهل اللسان على ذم العبد بمخالفة هذه الصيغة
والثاني اتفاق أهل اللغة والنحو على التمييز بين الأمر والنهي في أقسام
الكلام وهم الواسطة بيننا وبين العرب فبطل ما قالوا
مسألة 3
إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب وقالت الأشعرية إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء وجب التوقف فيها
ولا تحمل على الوجوب ولا على غيره إلا بدليل
وقالت المعتزلة يقتضي الأمر الندب ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل وهو قول
بعض أصحابنا
لنا قوله عز و جل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك فوبخ الله تعالى إبليس على
ترك السجود ومخالفة الأمر فدل على أنه يقتضي الوجوب
فإن قيل يجوز أن يكون الأمر الذي وبخه على مخالفته قارنته قرينة تقتضي
الوجوب فخالف ذلك فلهذا استحق الذم والتوبيخ
والجواب أن الظاهر يقتضي تعلق التوبيخ بمجرد الأمر من غير قرينة ألا تراه
قال إذ أمرتك ولم يذكر قرينة فمن ادعى انضمام قرينة إلى الأمر فقد خالف
الظاهر
وجواب آخر وهو أن الله سبحانه ذكر الأمر في موضع آخر فقال وإذ
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وليس معه قرينة فالظاهر أنه
وبخه على مخالفته هذا الأمر
ويدل عليه قوله عز و جل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو
يصيبهم عذاب أليم فتواعد على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه و سلم فدل
على أن أوامره كلها تقتضي الوجوب
وأيضا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن
يكون لهم الخيرة فهذا نص في إيجاب الأمر ونفي التخيير بين الفعل والترك
فإن قيل هذا يدل على وجوب أوامر الله تعالى وأوامر الرسول عليه السلام
وكلامنا في مقتضى اللفظ في اللغة
قلنا القصد بهذه المسألة أوامر الله تعالى وأوامر رسوله عليه السلام وإذا
ثبت الوجوب في أمرهما حصل المقصود
ويدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم دعا رجلا فلم يجبه وهو في
الصلاة فقال له ما منعك أن تجيبني قال كنت في الصلاة فقال له ألم تسمع
الله
يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما
يحييكم فوبخه على مخالفة الأمر فدل على أن الأمر يقتضي الوجوب
فإن قيل نحن لا نمنع أن يكون في الشرع أمر مخصوص يقتضي الوجوب ويستحق
التوبيخ على مخالفته وإنما الخلاف في مقتضى اللفظ في الجملة فلا يجوز
الاحتجاج عليه بأوامر مخصوصة
والجواب أنه ليس عندهم أمر يستحق التوبيخ على مخالفته لكونه أمرا والخبر
يقتضي تعلق التوبيخ بترك الأمر فحسب
ويدل عليه ما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لبريرة كنت لو راجعته
فإنه أبو ولدك فقالت بأمرك يا رسول الله فقال لا إنما أنا شفيع فقالت لا
حاجة لي فيه فمعلوم أن إجابة النبي صلى الله عليه و سلم فيما يشفع فيه
مستحقة فلما فرق بين الأمر والشفاعة دل على أنه لو أمر لاقتضى الوجوب
وأيضا قوله عليه السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
فدل على أنه لو أمر به لوجب وأن شق
ويدل عليه أن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه
استحق التوبيخ واللوم بإجماع عقلاء أهل اللسان ولو لم يقتض الأمر الإيجاب
لما حسن لومه وتوبيخه
فإن قيل إنما استحق اللوم لأنه قد اقترن بالأمر ما اقتضى الإيجاب من شاهد
الحال
قلنا لم يوجد أكثر من مجرد الصيغة فدل على أن اللوم تعلق بمخالفتها
وأيضا فإن أهل اللسان فرقوا بين السؤال والأمر فقالوا إذا قال لمن هو دونه
افعل أن هذا أمر وإذا قال لمن هو فوقه افعل قالوا هذا سؤال ولو كان الأمر
لا يقتضي الوجوب لم يكن لهذا الفرق معنى
والذي يدل على إبطال قول المعتزلة خاصة أن المنهي يقتضي ترك المنهي عنه
على سبيل الوجوب فكذلك الأمر يجب أن يقتضي فعل المأمور به على سبيل الوجوب
لأن كل واحد منهما أمر إلا أن أحدهما أمر بالفعل والآخر أمر أمر بالترك
فإن قيل النهي عندنا لا يقتضي وجوب ترك المنهي عنه بنفسه وإنما يقتضي
كراهية المنهي عنه كما أن الأمر يقتضي إرادة المأمور به غير أن الكراهية
من الحكيم تقتضي قبح المنهي عنه فوجب تركه والإرادة تقتضي حسن المأمور به
من الحكيم والحسن قد يكون واجبا وقد يكون نفلا فلم يجب فعله
والجواب أن الحكيم قد يكره الشيء كراهة تنزيه وهو أن يكون تركه أولى من
فعله ولا يكون قبيحا كنهيه عن الالتفات في الصلاة وغير ذلك مما يكره
كراهية التنزيه وقد ينهى عما هو قبيح كنهيه عن الزنا والسرقة
وغير ذلك فلم يكن حمله على التحريم بأولى من حمله على التنزيه ولما حملوه
على التحريم دل على أن مقتضى الأمر الإيجاب
وجواب آخر وهو أنه إن كان النهي يقتضي الوجوب لما ذكروه وجب أن يقتضي
الأمر الوجوب لأنه ما من أمر إلا وهو يتضمن النهي عن ضده والنهي عن ضده
يقتضي قبحه لأن الحكيم لا ينهى إلا عن قبيح ولا يمكن تركه إلا بفعل
المأمور به فوجب أن يكون مقتضى الأمر الإيجاب
ولأن الأمر موضوع لاقتضاء الفعل فوجب أن يحمل على وجه يحصل معه الفعل ومتى
حملناه على الندب جوزنا له تركه ولا يمكن إلا بفعل ذلك يوجب الإخلال
بموضوع اللفظ
احتج من قال بالوقف بأن هذه الصيغة ترد والمراد بها الإيجاب وترد والمراد
بها الاستحباب وترد والمراد بها الإباحة وليس حملها على أحد هذه الوجوه
بأولى من حملها على الوجه الآخر فوجب التوقف فيها كاللون والعين
والجواب أن هذا يبطل بقوله أوجبت وفرضت فإنه قد يستعمل في غير الوجوب وهو
قوله عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم
وقوله عليه السلام المضمضة والاستنشاق فريضتان في الجنابة ثلاثا
ثم إطلاقه يحمل على الوجوب وعلى أن هذا اللفظ بمجرده موضوع للإيجاب ويرد
والمراد به الندب بقرينة تقترن به كالحمار موضوع بمجرده موضوع للبهيمة
ويستعمل في الرجل البليد بقرينة والأسد موضوع للبهيمة المفترسة ويستعمل في
الرجل الشجاع بقرينة فكذلك ههنا ويفارق ما ذكروه من اللون والعين وغيرهما
من الأسماء المشتركة فإن ذلك غير موضوع بمجرده لشيء بعينه وقد بينا أن هذا
اللفظ بمجرده موضوع في اللغة للإيجاب فإذا حمل على الندب كان بقرينة تقترن
به ودلالة تدل عليه
فإن قيل ما الفرق بينك وبين المعتزلة أن لفظ الأمر بمجرده موضوع للندب ثم
نحمله على الوجوب بدليل القرينة
قلنا القرآن فصل بينهما وهو قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك وقول
السيد من العرب لعبده اسقني ماء وهذان الدليلان فصل بينهما
واحتجوا بأن دعوى الإيجاب في هذه الصيغة لا يخلو إما أن تكون بالعقل أو
بالنقل
والعقل لا يوجب ذلك
والنقل لا يخلو إما أن يكون متواترا أو أحادا
وليس يقبل فيه الآحاد لأنه من مسائل الأصول
وليس فيه تواتر لأنه لو كان لأوجب العلم ضرورة لنا ولكم ولما لم
يقع العلم دل على أنه ليس فيها تواتر فلا معنى لحملها على الإيجاب
والجواب أن هذا ينقلب عليهم في دعواهم أن هذا اللفظ مشترك بين الوجوب
والاستحباب والإباحة فإنهم أثبتوا هذا الاشتراك وليس معهم في ذلك واحد من
الطريقين على ما ساقوه
وجواب آخر وهو أنا قد بينا ذلك بالاستدلال من أفعالهم على مقاصدهم وعلمنا
بضربهم العبيد على المخالفة أنهم وضعوا هذه الصيغة للإيجاب
ولأنهم إن كلمونا في أوامر صاحب الشرع فقد بينا من القرآن والسنة المتلقاة
بالقبول ما يدل على الوجوب فوجب حملها على ذلك
واحتجوا بأن استعمال هذا اللفظ في الندب والإباحة أكثر من استعماله في
الوجوب ولا يجوز أن يكون موضوعا للوجوب ثم يستعمل في غير موضعه أكثر
قلنا لا نمنع أن يكون موضوعا للوجوب ثم يستعمل في غيره أكثر ألا ترى أن
الوطء اسم للدوس في اللغة حقيقة ثم صار استعماله في الجماع أكثر فكذلك
ههنا لا يمتنع أن يكون مثله
واحتج المعتزلة بأن الأمر من الحكيم يقتضي حسن المأمور به إذ لا يجوز أن
يريد الإباحة في دار التكليف وحسنه لا يقتضي أكثر من الندب وأما الزيادة
على ذلك فلا تقتضيه فحملناه على أدنى ما يقتضيه اللفظ
والجواب أن هذه ددعوى وشرح لمذهبهم وأنه لا يقتضي أكثر من ذلك
وليس قولهم في هذا هذا إلا كقول من يقول في قوله أوجبت عليك أنه لا يقتضي
أكثر من ذلك فلا يحمله على الإيجاب
ثم هذا يبطل بالنهي فإنه يدل من الحكيم على كراهية المنهي عنه وكراهيته لا
تقتضي التحريم لأنه قد يكره كراهية تنزيه ثم لم يحمل على أدنى ما تتناوله
الكراهة فبطل ما قالوه
وجواب آخر وهو أنه إن كان الأمر يقتضي حسن المأمور به فهو يقتضي قبح ضده
ولا يمكنه ترك ضده إلا بفعل المأمور به فوجب أن يكون واجبا
واحتج بأنه لو كان ذلك يقتضي الوجوب لما حسن من الولد مع والده والعبد مع
سيده وقد رأينا الجميع يتخاطبون بينهم بذلك فدل على أنه لا يقتضي الوجوب
ألا ترى أن قوله فرضت وألزمت لما اقتضى الوجوب لم يتخاطب به العبيد
والسادة
قلنا هذا يبطل بلفظ النهي فإن الجميع يتخاطبون به فيما بينهم ثم ظاهره
الوجوب
ولأن استعمال اللفظ في بعض المواضع التي لا تحتمل الوجوب لا يدل على أنه
غير موضوع للوجوب
ألا ترى أن الحمار يستعمل في موضع لا يحتمل البهيمة كقولهم في البليد هذا
حمار ثم لا يدل على أنه غير موضوع للبهيمة المخصوصة وكذلك ها هنا مثله
قالوا ولأن قوله افعل لمن هو فوقه يقتضي الإرادة دون الوجوب
فكذلك لمن هو دونه وجب أن يقتضي الإرادة دون الوجوب
قلنا يبطل بالنهي ثم هذا اللفظ لمن هو فوقه يسمى سؤالا وطلبا ولمن هو دونه
يسمى أمرا فدل على الفرق بينهما
واحتجوا بأن قوله افعل وقوله أريد منك أن تفعل واحد لأن كل واحد منهما
يقتضي إرادة المأمور به فإذا لم يقتض أحدهما الإيجاب لم يقتضي الآخر
قلنا لا نسلم هذا بل معنى قوله افعل استدعاء الفعل ومعنى قوله أريد منك أن
تفعل إخباره عما يريده ولهذا يدخل الصدق والكذب في أحدهما دون الآخر ولأن
قوله أريد يسمى مسألة وطلبا وقوله افعل يسمى أمرا فافترقا
مسألة 4
المندوب إليه غير مأمور به في أحد الوجهين ومأمور به في الوجه الثانيفوجه الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لبريرة كنت لو راجعته فإنه أبو ولدك قالت يأمرك يا رسول الله فقال لا إنما أنا شفيع وإجابة النبي صلى الله عليه و سلم فيما يشفع فيه مندوب إليه فلو كان المندوب مأمورا به لما امتنع من كونه أمرا
وأيضا فإنه لو كان المندوب إليه مأمورا به لحسن أن يقال لكل من ترك مستحبا من إماطة الأذى عن الطريق وصلاة التطوع وصوم التطوع عصيت الله
تعالى وخالفت أمره كما يحسن أن يقال ذلك لكل من ترك الواجب
ولما لم يجز أن يقال هذا دل على أنه غير مأمور به
واحتج من قال بالوجه الثاني بأنه طاعة فكان مأمورا به كالواجب
والجواب أن الواجب لم يكن مأمورا به لكونه طاعة وإنما صار مأمورا به لأنه
يجب فعله ويعصى بتركه وفي مسألتنا لا يجب فعله ولا يعصى بتركه فافترقا
قالوا ولأن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والندب ما يثاب على
فعله ولا يعاقب على تركه فإذا حمل على الندب فقد حمل على بعض ما يشتمل
عليه الواجب فكان حقيقة فيه كما لو حملوا العموم على بعض ما يتناوله
قلنا لا نسلم أن معنى الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وإنما
الواجب ما يعاقب على تركه ويدخل الثواب على فعله على وجه التبع وهو أنه
لما امتثل الأمر صار مثابا عليه ويخالف العموم فإن لفظه يتناول الجنس كله
فإذا خرج بعضه بالدليل بقي اللفظ متناولا للباقي فكان حقيقة فيه
مسألة 5
إذا ورد الأمر بعد الحظر متجردا على القرائن اقتضى الوجوبومن أصحابنا من قال يقتضي الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي
لنا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره ولم يفصل بين أن يتقدمه حظر أو لا يتقدمه حظر
ويدل عليه هو أن الأمر ورد متجردا عن القرائن فاقتضى الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر
فإن قيل لا نسلم أنه ورد متجردا عن القرائن بل تقدم الحظر عليه قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره وذلك أن الظاهر أنه يرفع ما تقدم من الحظر
والجواب أن القرينة ما يبين معنى اللفظ ويفسره وذلك إنما يكون
بما يوافق اللفظ ويماثله فأما ما يخالفه ويضاده فلا يجوز أن يكون بيانا له
فلا يجوز أن يجعل قرينة
وأيضا أنه لا خلاف أن النهي بعد الأمر يقتضي الحظر فكذلك الأمر بعد النهي
وجب أن يقتضي الوجوب
ولأن كل واحد من اللفظين مستقل بنفسه فلا يتغير معه مقتضى الثاني بتقدم
الأول كما لو قال حرمت عليك كذا ثم قال أوجبت عليك كذا ولا يلزم قولهم
فلان بحر حيث حملنا البحر على وصف الرجل دون الماء الكثير لأن البحر غير
مستقل بنفسه فاعتبر حكمه بنفسه ألا ترى أنه لو لم يصله بما قبله لم يفد
فجعل وصفا لما قبله وههنا الكلام مستقل بنفسه فاعتبر حكمه بنفسه
واحتجوا بأن الظاهر من هذا الأمر أنه قصد به رفع الجناح فيما حظر عليه
يدل عليه أن السيد إذا منع عبده من فعل شيء ثم قال له افعله كان المعقول
من هذا الخطاب إسقاط التحريم دون غيره فكذلك ههنا
الجواب أنا لا نسلم ما ذكروه بل الظاهر أنه قصد الإيجاب لأن اللفظ موضوع
للإيجاب والمقاصد تعلم بالألفاظ
ولأن هذا نسخ للحظر والحظر قد ينسخ بإباحة وقد ينسخ بالإيجاب وليس حمله
على الإباحة بأولى من حمله على الإيجاب فتعارض الاحتمالان في ذلك وبقي
اللفظ على مقتضاه في الإيجاب
ولأنه لو جاز أن يقال هذا في الأمر بعد الحظر إن القصد به رفع الجناح فلم
يقتض الجواب لجاز أن يقال في النهي بعد الأمر إن القصد منه إسقاط الوجوب
وإباحة الترك فلا يقتضي الحظر
واحتجوا بأن كل أمر ورد في الشرع بعد الحظر فالمراد به الإباحة كقوله
عز و جل وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فإذا
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فدل على أن هذا مقتضاه
فالجواب أنه قد ورد أيضا والمراد به الوجوب وهو قوله تعالى فإذا انسلخ
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين
وعلى أنا إنما حملنا هذه الأوامر على الإباحة بدلالات دلت عليها وهذا لا
يدل على أن ذلك مقتضاها ألا ترى أن أكثر ألفاظ العموم في الشرع محمولة على
الخصوص ثم لا يدل على أن مقتضاها الخصوص فكذلك ههنا
واحتجوا بأن الأشياء في الأصل على الإباحة فإذا ورد بعد الحظر ارتفع الحظر
وعاد إلى الأصل وهو الإباحة
والجواب أنا لا نسلم أن الأشياء في الأصل على الإباحة بل هي على الوقف في
أصح الوجوه
وعلى أن هذا يبطل به إذا قال بعد الحظر أوجبت فإنه يحمل على الوجوب ولا
يقال إن الأشياء في الأصل على الإباحة فيرتفع الحظر بهذا اللفظ ويعود إلى
الأصل وهو الإباحة
ولأنه لو جاز أن يقال هذا في الأمر بعد الحظر لجاز أن يقال في النهي بعد
الأمر إنه لا يقتضي التحريم لأن الأشياء في الأصل على الإباحة فإذا ورد
النهي بعد الأمر ارتفع الوجوب وعاد إلى أصله وهو الإباحة ولما لم يصح هذا
في النهي بعد الأمر لم يصح في الأمر بعد النهي
مسألة 6
الأمر المجرد لا يقتضي التكرار في قول أكثر أصحابنا ومنهم من قال إنه يقتضي التكرار لنا أن قوله صل أمر كما أن قوله صلى خبر عنه ثم ثبت أن قوله صلى
لا يقتضي التكرار فكذالك قوله صل
وأيضا أن قوله صل وصم لا يقتضي أكثر من إيجاد ما يسمى صلاة وصوما
يدل عليه أنه إذا فعل صوما وصلاة حسن أن يقول صمت وصليت فإذا فعل ما
يقتضيه اللفظ لم تلزمه زيادة إلا بدليل
ويدل عليه أنه لو حلف ليفعلن كذا بر بفعل مرة واحدة ولو كان اللفظ يقتضي
التكرار لما بر بفعل مرة واحدة كما لو حلف ليفعلن كذا على الدوام
وأيضا أنه لو قال لوكيله طلق امرأتي لم يجز أن يطلق أكثر من طلقة فلو كان
الأمر يقتضي التكرار لملك الوكيل إيقاع ثلاث تطليقات كما لو قال طلق ما
شئت أو كل ما أملكه
فإن قيل مقتضى اللفظ في اللغة في ما ذكرتم من اليمين والتوكيل التكرار
وإنما تركنا مقتضى اللفظ بالشرع ويجوز أن يكون اللفظ في اللغة يقتضي أمرا
ثم يقرر الشرع فيه على غير مقتضاه في اللغة فيحمل على ذلك ولا يدل على أن
ما في لم يقرر الشرع فيه شيئا لا يحمل على مقتضاه في اللغة كما لو حلف لا
يأكل الرؤوس فإنا نحمل ذلك بالشرع على رؤوس النعم خاصة ثم لا يدل على أن
الرؤوس في اللغة لا يقتضي سائر الرؤوس
والجواب عنه أن الأمر في اليمين والوكالة محمول على موجب اللغة والشرع ورد
فيهما بمراعاة موجب اللغة ولهذا لو قيد كل واحد منهما بما يقتضي التكرار
لحمل على التكرار وهو أن يقول والله لأفعلن كذا أبدا أو يقول لوكيله طلق
امرأتي كل ما أملكه من الطلاق فلو لم يكن مقتضى اللفظ في اللغة ما ذكرناه
لم يحمل عليه
وأما إذا حلف على أكل الرؤوس فإنما حملناه على رؤوس النعم لأن
في عرف أهل اللغة لا يطلق اسم الرؤوس إلا على هذه الرؤوس فراعينا في ذلك
أيضا موجب اللغة وعرف أهل اللسان فيجب أن يكون هاهنا أيضا يراعى موجب
اللغة وعرف اللسان
واحتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في شارب الخمر اضربوه
فكرروا عليه الضرب ولو لم يكن مقتضى الأمر التكرار لما كرروا عليه الضرب
والجواب أنهم إنما حملوا اللفظ على التكرار لقرينة اقترنت باللفظ وهو شاهد
الحال وذلك أنهم علموا أن قصده الردع والزجر وأن ذلك لا يحصل إلا بتكرار
الضرب وخلافنا في الأمر المتجرد عن القرائن
وأيضا ما روي عن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه و سلم أحجنا هذا
في كل سنة أم في العمر مرة واحدة
فلو كان الأمر يقتضي مرة واحدة لم يكن لهذا السؤال معنى
قلنا هذا مشترك الدليل فإنه لو كان مقتضاه التكرار لم يكن لهذا السؤال
معنى
فكل جواب لهم عن سؤاله عن التكرار واللفظ موضوع له فهو جوابنا عن سؤاله
مرة واحدة واللفظ موضوع له
ولأنه إنما حسن السؤال لأن اللفظ يحتمل التكرار ومع الاحتمال
يحسن السؤال فبطل تعلقهم به
واحتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا
منه ما استطعتم
والجواب أنه إنما أمر بأن يؤتى من الأمر ما استطاع منه وعندنا الدفعة
الثانية ليست من الأمر وإنما الأمر من الدفعة الأولى فيجب أن نأتي منها
بما نستطيع
واحتجوا بأن أكثر أوامر الشرع على التكرار فدل على أن ذلك مقتضى الأمر
قلنا هذا يبطل بألفاظ العموم فإن أكثرها على التخصيص ولا يدل على أن ذلك
مقتضاها
وعلى أنا إنما حملنا تلك الأوامر على التكرار لقيام الدلالة عليها وخلافنا
في الأمر المتجرد عن الدليل
وعلى أن ما ذكروه دليل لنا فإن الأوامر التي ذكروها لم نحملها على التكرار
على الدوام وإنما حملناها على التكرار في أوقات مخصوصة وعندهم أن الأمر
يقتضي التكرار على الدوام فبطل ما قالوه
قالوا لا خلاف أن النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر
قلنا فرق بين اللفظ الموضوع للنفي وبين اللفظ الموضوع للإثبات
ألا ترى أنه لو قال والله لا فعلت كذا لم يبر إلا بالتكرار والدوام ولو
قال والله لأفعلن كذا بر بمرة واحدة فدل على الفرق بينهما
ويدل عليه أنه لو كان النفي في الخبر بأن قال ما فعلت كذا اقتضى
التكرار ولو كان للإثبات في الخبر بأن قال فعلت كذا اقتضى ما يقع عليه
الاسم
ولأن النهي لو قيده بمرة واحدة اقتضى التكرار ولو قيد الأمر بمرة واحدة لم
يقتض التكرار فدل على الفرق بينهما
واحتجوا بأن قوله صل يحتمل صلاة وأكثر من صلاة على طريق الحقيقة ألا ترى
أنه يجوز أن يفسر بالجميع فوجب أن يحمل اللفظ على الكل
والجواب أنه يبطل بقوله صليت لأنه يحتمل صلاة وأكثر على ما ذكروه ثم لا
يحمل إطلاقه إلا على أدنى ما يتناوله الاسم
واحتجوا بأنه لو قال احفظ هذا فحفظه ساعة ثم ترك حفظه استحق التوبيخ
والعقوبة ولو لم يقتض الدوام لما حسن توبيخه وعقوبته
والجواب أن معنى الحفظ أن لا يضيع فإذا حفظه ساعة ثم تركه صار مضيعا فلم
يجعل ممتثلا للأمر فلهذا أوجب عليه على الدوام وليس كذلك إذا قال صل فإن
ذلك يقتضي تحصيل ما يسمى صلاة وذلك يحصل بفعل صلاة واحدة فافترقا
ويدل عليه أنه لو حفظ ساعة ثم خلاه لم يحسن منه أن يقول حفظت ولو صلى صلاة
واحدة حسن أن يقول صليت فافترقا
ولأن البر في اليمين على الحفظ لا يحصل إلا بالمداومة والبر في اليمين على
الصلاة وسائر الأفعال يحصل بأدنى ما يتناوله الاسم فدل على الفرق بينهما
واحتجوا بأن الأمر يقتضي وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد ثم اعتقاد الفعل يجب
تكراره فكذلك الفعل
قلنا لا يمنع أن يجب تكرار الاعتقاد دون الفعل كما لو قال صل مرة فإن
الاعتقاد يتكرر وجوبه والفعل لا يتكرر وجوبه
ولأن الاعتقاد ليس يجب بالأمر وإنما يجب بمعنى آخر وهو أن الأمر
يتضمن الخبر بوجوبه فإذا ذكر المكلف الأمر ولم يعتقد وجوبه صار مكذبا له
في خبره فيصير كافرا بذلك فوجب عليه اعتقاد الوجوب كلما ذكر الأمر وليس
كذلك الفعل فإنه يجب بالأمر وقد بينا أن اللفظ لا يقتضي إلا أدنى ما
يتناوله الاسم فافترقا
قالوا الأمر بالصلاة عام في جميع الزمان كما أن لفظ العموم عام في الأعيان
والذي يدل عليه أنه يصح استثناء ما شاء من الأوقات كما يصح في العموم
استثناء ما شاء من الأعيان ثم ثبت أن العموم في الأعيان يقتضي استغراق
جميعهم فكذلك الأمر في الأزمان وجب أن يقتضي استغراق جميعها وفي إثبات هذا
إثبات التكرار
والجواب أن لفظ الأمر لا يتناول الزمان وإنما يتناول الفعل غير أن الفعل
لا يقع إلا في زمان فلم يجب حمله على العموم فيما لم يتناوله ويخالف في
هذا العموم في الأعيان بأن اللفظ يتناول الأعيان فحمل على عمومه
يدل عليه أنه لو قال والله لأقتلن المشركين حمل ذلك على عامتهم ولو قال
والله لأقتلن لم يحمل ذلك على جميع الأعيان بل إذا قتل واحدا بر فافترقا
مسألة 7
إذا علق الأمر بشرط وقلنا إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهانأصحهما لا يقتضي التكرار
ومن أصحابنا من قال يقتضيه
لنا هو أن كل أمر اقتضى مرة واحدة إذا كان مطلقا اقتضى مرة
واحدة وإن كان معلقا هو شرط كما لو قال صل وصم
ولأنه إذا كان المطلق لا يقتضي التكرار فالمعلق بشرط مثله لأن الشرط إنما
يفيد تعلق المطلق عليه فقط فإذا لم يقتض المطلق التكرار وجب أن لا يقتضي
المعلق بشرط
ولأن أهل اللسان فرقوا بين قولهم افعل كذا إذا طلعت الشمس وبين قولهم افعل
كذا كلما طلعت الشمس ولهذا قال الفقهاء فيمن قال لزوجته أنت طالق إذا طلعت
الشمس فإنه يقع الطلاق عليه مرة واحدة ولا يعود ولو قال أنت طالق كلما
طلعت الشمس تكرر وقوع الطلاق لتكرر الشرط ولم يفرقوا بين اللفظين إلا
لاختلافهما في موجب اللغة
وأيضا فإن تعليق الأمر بالشرط يقتضي تخصيصه فإذا كان مطلقه في الأحوال
كلها لا يقتضي التكرار فالمخصوص ببعض الأحوال أولى بذلك
واحتج القائل الآخر بأن تعلق الحكم بالشرط كتعلقه بالعلة إذ كل واحد منهما
سبب فيه فإذا كان تكرار العلة يوجب تكرار الحكم فكذلك تكرار الشرط
قيل لا نسلم هذا بل بينهما فرق ظاهر وهو أن العلة دلالة تقتضي الحكم فتكرر
الحكم بتكررها والشرط ليس بدلالة على الحكم ألا ترى أنه لا يقتضيه وإنما
هو مصحح له فدل على الفرق بينهما
واحتج بأن أوامر الله تعالى المعلقة بالشروط كلها على التكرار
كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وكقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم ونحو ذلك فدل على أن ذلك مقتضاه
والجواب أن في أوامره المعلقة على الشرط ما لا يقتضي التكرار كالأمر بالحج
ولأن أوامر الشرع اقترنت بها أدلة تقتضي التكرار من الإجماع والقياس
وغيرهما وليس فيما اختلفا فيه دلالة تقتضي التكرار فبقي على ظاهره
واحتج أيضا بأن النهي المعلق بالشرط يقتضي التكرار فكذلك الأمر
والجواب هو أن من أصحابنا من سوى بين الأمر والنهي إذا تعلق بالشرط
وإن سلمنا فإن الأمر مخالف للنهي ألا ترى أن الأمر المطلق لا يقتضي
التكرار والنهي المطلق يقتضيه
ولأنا بينا الفرق بينهما فيما مضى بما يغني عن الإعادة
مسألة 8
تكرار الأمر بالشيء يقتضي تكرار المأمور به وقال الصيرفي لا يقتضي التكرار
لنا أن كل واحد من اللفظين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد فإذا اجتمعا
وجب أن يقتضيا التكرار كما لو كانا بفعلين مختلفين
وأيضا أن المقتضي للفعل هو الأمر والثاني كالأول في الإفادة فوجب أن يكون
كالأول في الإيجاب
واحتج بأن أوامر الله تعالى في القرآن قد تكررت ولم تقتض تكرار الفعل
والجواب أنا تركنا الظاهر في تلك الأوامر للدلالة
قالوا ولأن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا نوجب فعلا
مستأنفا بالشك
والجواب أنا لا نسلم أن ذلك شك بل هو ظاهر فإن الظاهر أنه ما كرر إلا
للاستئناف فيجب أن يحمل عليه
واحتج أيضا بأن السيد إذا قال لعبده اسقني ماء ثم كرر ذلك لم يقتض التكرار
فكذلك ههنا
قلنا لا نسلم هذا إلا أن يكون في الحال ما يدل على أنه قصد التأكيد فيحمل
عليه لدلالة الحال
وإن سلمنا فلأن الأمر منا لا غرض له في تفريق الأمر فلو كان أراد شيئين
لجعلهما في لفظ واحد وصاحب الشرع قد يرى المصلحة في تفريق الأمر فحمل ذلك
على شيئين مختلفين
مسألة 9
الأمر المطلق لا يقتضي الفعل على الفور في قول أكثر أصحابناوقال أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو حامد
إنه يقتضي الفور وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة
وقال بعض المتكلمين يتوقف فيه إلى أن يقوم الدليل على ما أريد به من الفور
أو التراخي
لنا أن الأمر يقتضي استدعاء الفعل وليس للزمان فيه ذكر ففي أي وقت فعله
وجب أن يصير ممتثلا
يدل عليه أنه لما اقتضى الفعل ولم يكن لحال الدخول فيه ذكر جاز فعله في كل
حال من أحواله فيصير ممتثلا كذلك في الزمان مثله
ويدل عليه أن الأمر لا يقتضي زمانا ولا مكانا وإنما يحتاج إلى زمان ومكان
لأن أفعال المخلوقين لا تقع إلا في زمان ومكان ثم ثبت أنه في أي مكان فعل
صار ممتثلا وكذلك في أي زمان فعل وجب أن يصير ممتثلا
ويدل عليه أن الامتثال في الأمر كالبر في اليمين ثم لو قال والله
لأفعلن كذا صار بارا في اليمين وإن أخر الفعل عن حال اليمين
فكذلك يجب أن يصير ممتثلا في الأمر وإن أخره عن حال الأمر
ويدل عليه أن قوله اقتل مطلق في الأزمان كما أنه مطلق في الأعيان ثم إنه
لا خلاف أنه يصير ممتثلا بقتل من شاء فوجب أن يصير متمثلا بالقتل في أي
وقت شاء ولهذا قال عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما وقد صدوا
عن البيت يوم الحديبية أليس قد وعدنا الله بالدخول فكيف صدونا فقال له أبو
بكر الصديق إن الله تعالى وعد بذلك ولكن لم يقل في أي وقت فدل على أن
اللفظ لا يقتضي الوقت الأول
واحتجوا بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وفي فعل الطاعة مغفرة
فوجبت المسارعة إليها
الجواب أن المراد بالآية التوبة من الذنوب والإنابة إلى الله تعالى
والذي يدل عليه هو أن التوبة هي التي تتعلق بها المغفرة في الحقيقة فوجب
حمل الآية عليها
واحتجوا بأنه أحد نوعي خطاب التكليف فكان على الفور كالنهي
قلنا النهي يتناول الانتهاء في جميع الأوقات على الدوام والاتصال فيعلق
بالوقت الأول كما يعلق بجميع الأوقات وليس كذلك الأمر فإنه لا
يقتضي أكثر من وقت واحد وليس الوقت الأول بأولى من الوقت الثاني فكان جميع
الأوقات فيه واحدا
واحتجوا أيضا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا يصير منتهيا عن ضده إلا
بفعل المأمور به على الفور
والجواب أنه يبطل به إذا قال له افعل في أي وقت شئت فإنه يجوز له التأخير
وإن أدى إلى ما ذكروه
وجواب آخر وهو أنه لو كان هذا صحيحا لوجب أن يحمل الأمر على التكرار لأن
الأمر بالشيء نهي عن ضده فيجب أن يداوم على الفعل ليصير منتهيا على الدوام
وجواب آخر وهو أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من طريق اللفظ فيراعى فيه
موجب لفظ النهي وإنما هو نهي من طريق المعنى فإنه لا يجوز أن يكون مأمورا
بالشيء إلا وضده محرم عليه فلم يتعلق ذلك إلا بما يفوت به المأمور فإذا
كان الأمر بفعل واحد اقتضى ذلك تحريم ما يفوت به الفعل وذلك لا يقتضي
المسارعة إلى المأمور به
واحتجوا بأن الأمر يقتضي ثلاثة أشياء الفعل والعزم عليه واعتقاد الوجوب ثم
العزم والاعتقاد على الفور فكذلك الفعل
والجواب عن الاعتقاد ما قضي في مسألة الأمر هل يقتضي التكرار وأما العزم
فلم يكن على الفور بموجب اللفظ بل كان على الفور لأن المكلف لا ينفك من
العزم على الفعل والترك فالعزم على الترك معصية وعناد لصاحب
الشرع فتعين العزم على الفعل وأما الفعل فهو موجب اللفظ وليس في
اللفظ ما يوجب التعجيل فافترقا
ولأنه لو قيد الأمر بالتراخي لوجب العزم على الفور والفعل على التراخي فدل
على الفرق بينهما
واحتجوا بأن قوله افعل يقتضي إيجاد الفعل فلو قلنا أنه على التراخي
لأثبتنا تخييرا لا يدل عليه اللفظ
والجواب أنه يبطل به إذا قال اقتل فإنه ليس في اللفظ تخيير ثم يتخير في
أعيان المقتولين
ولأن هذا يعارضه أن اللفظ يقتضي إيجاد الفعل فمن جعله على الفور فقد زاد
في اللفظ زيادة وأثبت تخصيصا لا يدل عليه اللفظ وهذا لا يجوز
واحتجوا بأن السيد إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه على الفور استحق
التوبيخ فدل على أن مقتضاه الفور
والجواب أنه إن لم تكن هناك قرينة تقتضي الفور لم يستحق التوبيخ وإنما
يستحق ذلك إذا اقترن بالأمر قرينة يعلم بها الفور فيستحق التوبيخ على ذلك
لمكان الدلالة
واحتجوا بأنا أجمعنا على كون الفعل قربة في أول الوقت فمن أثبت القربة في
الوقت الثاني احتاج إلى دليل
والجواب أن الذي اقتضى كون الفعل قربة في الوقت الأول تناول الأمر وقد
بينا أن تناوله للوقت الثاني والأول واحد فوجب أن يكون قربة في الجميع
واحتجوا بأنه لو قال له افعل وعجل صح وكان ذلك حقيقة فيه ولو لم
يكن ذلك حقيقة في الأمر لوجب أن يكون مجازا
والجواب أن هذا حجة عليهم فإنه لو كان الأمر يفوت بترك التعجيل لما حسن أن
يقول له افعل وعجل ألا ترى أن الصوم لما فات بفوات الوقت لم يحسن أن يقول
صم وعجل ولما حسن أن يقول له افعل كذا وعجل دل على أنه لا يفوت بالتأخير
ثم هذا يبطل به إذا قال اقتل زيدا فإنه يصح ويكون حقيقة ثم لا يقال إن
مقتضى اللفظ المطلق منه قتل زيد خاصة لأنه لو لم يكن ذلك مقتضاه لوجب أن
يصير مجازا
وعلى أن اللفظ إنما يصير مجازا إذا وضع لشيء بعينه ثم استعمل في غيره
كالحمار موضوع للبهيمة المخصوصة فإذا استعمل في الرجل البليد كان مجازا
وأما لفظ الأمر فإنه غير موضوع لزمان ولا متناولا له من حيث اللفظ وإنما
يتناول الفعل فحسب والزمان إنما يحتاج إليه لضرورة فعل المكلف ففي أي وقت
استعمل لم يصر مجازا
قالوا ولأنه استدعاء فعل بقول مطلق فاقتضى التعجيل كالإيجاب في البيع
قلنا الإيجاب لم يقتض القبول على الفور من جهة اللغة وإنما اقتضى ذلك من
جهة الشرع ولهذا لو رضي البائع أن يقبل على التراخي لم يجز وكلامنا في
مقتضى اللفظ في اللغة فلا يجوز أن يستدل عليه بالشرعيات
واحتجوا بأنه إذا لم يفعل المأمور به حتى مات لم يخل إما أن لا يعصي بذلك
فيخرج الفعل عن أن يكون واجبا ويلحق بالنوافل أو يعصي فلا يخلو إما أن
يعصي بعد الموت وهذا لا يجوز لأنه لا طريق له إلى فعل
المأمور به بعد الموت فلا يجوز أن يلحقه العصيان أو يعصي إذا
غلب على ظنه أنه إذا أخره فاته الأمر وهذا لا يجوز لأنه قد يموت بغتة
ويخترم فجأة ولا يجوز أن يكون عاصيا فثبت أنه عصى من أول حال الإمكان وهذا
يدل على أنه وجب على الفور
والجواب أن هذا يبطل بقضاء رمضان والكفارات وما أخبرنا خبره من العبادات
فإن هذا التقسيم موجود فيه ثم وجوبها على التراخي
وجواب آخر وهو أن أبا علي بن أبي هريرة قال لا يعصي إذا مات ولا يلحق
بالنوافل لأنا نوجب عليه العزم على الفعل في الفرائض وفي النوافل لا يجب
ذلك
ومن أصحابنا من قال إنه يعصي إذا غلب على ظنه فواته فإن اخترم بغتة لم يعص
وهذا لا يمنع ألا ترى أن الوصية كانت واجبة قبل النسخ وكان وجوبها متعلقا
بهذا المعنى فلو اخترم فجأة لم يعص بتركها ولم يدل ذلك أنها غير واجبة
واحتجوا بأنه لو لم يتعلق الأمر بالوقت الأول لتعلق بوقت مجهول وذلك لا
يجوز كما لا يجوز تعليقه بوقت معين مجهول
والجواب هو أن فيما ذكروه لا يمكن امتثال الأمر فلم يجز وههنا يمكن امتثال
الأمر لأنه مخير في الأوقات كلها فجاز
يدل عليه هو أنه لا يجوز أن يعلق الأمر على قتل رجل بعينه غير معلوم وإن
علقه على رجل من المشركين غير معين جاز فافترقا
ومن قال بالوقف استدل بأنه يحتمل أن يجوز أراد به الإيجاب في
الوقت الأول ويحتمل الوقت الآخر ويحتمل ما بينهما ولا مزية لبعضهما على
بعض فوجب الوقف كما وجب في ألفاظ العموم
والجواب هو أن الوقف لا ذكر له في اللفظ وما ليس له ذكر وجب إسقاطه ولا
يجوز الوقف بسببه ألا ترى أنه إذا قال صل لم يجز أن يقف على معرفة أحوال
المكلف من كونه صائما أو مفطرا حاضرا أو مسافرا وإن لم يكن لبعض هذه
الأحوال مزية على بعض واحتمل الأمر الجميع احتمالا واحدا
وأما العموم فعندنا لا يتوقف فيه ثم الوقف في العموم أقرب من الوقف في
الأمر وذلك أن هنالك لفظ يحتمل العموم والخصوص فجاز أن يتوقف فيه إلى أن
نعلم المراد وليس للزمان لفظ يقتضيه والأصل عدمه فسقط الوقف لأجله كما سقط
الوقف لأجل المكان
مسألة 10
إذا أمر بعبادة في وقت أوسع من قدر العبادة كالصلاة تعلق الوجوب بأول الوقت وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة يتعلق بآخر الوقت
وقال أبو الحسين الكرخي يتعلق بوقت غير معين ويتعين بالفعل
لنا هو أن المقتضي للوجوب الأمر وهو قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس وهذا
تناول أول الوقت فاقتضى الوجوب فيه
وأيضا فإن تناول الأمر لأول الوقت كتناوله لآخره ولهذا يجوز فعل العبادة
فيهما بحكم الأمر فإذا اقتضى الوجوب في آخره وجب أن يقتضي الوجوب في أوله
فإن قيل لا يمنع أن يتناول الأمر الوقتين ثم يختلف حكمهما في الوجوب
ألا ترى أن الأمر قد تناولهما ثم اختلفا فتعلق الإثم بالتأخير
عن آخر الوقت ولم يتعلق بأوله
قيل تساويهما في الأمر يقتضي التسوية بينهما في الإيجاب لأن مقتضى الأمر
الوجوب فأما جواز التأخير وعدم جوازه فمن صفات الوجوب ويجوز أن تختلف صفة
الوجوب فتكون في أحدهما على الفور وفي الآخر على التراخي ويستويان في
الوجوب كما أن الأمر بالصوم والأمر بالحج يستويان في الإيجاب وإن كان في
أحد الوصفين على التراخي وفي الآخر على الفور
واحتجوا بأنه لو كان واجبا في أول الوقت لأثم بتأخيره ألا ترى أن في آخر
الوقت لما كان واجبا أثم بالتأخير ولما لم يأثم بالتأخير دل على أنه غير
واجب كالنفل
والجواب أن هذا يبطل بقضاء رمضان والكفارة لأنه لا يأثم بتأخيرهما ثم هما
واجبان
وعلى أن جواز التأخير إنما يدل على نفي الوجوب إذا لم يكن عذر وأما إذا
جوزنا تركه بعذر لم يدل على أنه غير واجب ألا ترى أن ترك غسل الرجل إلى
مسح الخف لما كان لعذر لم يدل على أنه غير واجب وفي مسألتنا إنما يترك
الصلاة في أول الوقت لعذر ظاهر وهو أنا لو ألزمناه فعلها في أول الوقت على
الفور لكان في ذلك مشقة شديدة لأنه يلزم لناس أن ينقطعوا عن أشغالهم
بمراعاة أول الوقت ليصادفوه بالعبادة وفي ذلك ضرر فسمح لهم بالتأخير لذلك
وهذا المعنى لا يوجد في آخر الوقت ولهذا يخالف النفل فإنه يجوز تركه من
غير عذر فلم يكن واجبا
ولأن جواز التأخير إنما يدل على نفي الوجوب إذا لم يجب العزم عليه فأما مع
وجوب العزم فلا يدل وههنا يجوز له التأخير بشرط أن يعزم على فعله في
الثاني فلم يدل على نفي الوجوب ولهذا يخالف النفل فإنه يجوز
تركه من غير عذر ومن غير عزم على فعله فلم يكن واجبا
ولأن جواز التأخير إنما يدل على نفي الوجوب إذا كان ذلك عن جميع الوقت
كالنفل الذي ذكروه فأما إذا جوزنا التأخير عن بعض الوقت دون بعض فلا وههنا
يجوز له التأخير عن بعض الوقت فلم يدل على نفي الوجوب
واحتج من قال إنه يتعلق بوقت غير معين بأنه مخير في الأوقات كلها فتعلق
الوجوب فيها بغير معين كما نقول في كفارة اليمين
والجواب أن كفارة اليمين حجة عليهم فإن الكفارة واجبة عليه عند الحنث وإن
خيرناه في أعيانها فيجب أن تكون الصلاة واجبة عند دخول الوقت وإن خيرناه
في أوقاتها
مسألة 11
إذا فات وقت العبادة سقطت ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثانومن أصحابنا من قال لا تسقط
لنا هو أن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلم يجب فيه الفعل كما قبل الوقت
ولأن تخصيص الأمر بالوقت كتخصيصه بالشرط ولو علق الأمر بالشرط لم يجب مع عدمه كذلك إذا علق بوقت
وأيضا هو أن النهي المؤقت يسقط بفوات الوقت وإذا ترك الانتهاء
في الوقت لم يجب قضاؤه في وقت آخر فكذلك الأمر
ولأنه لو علق الأمر بمكان بعينه لم يجب فعله بمكان آخر فكذلك إذا علقه
بزمان بعينه
فإن قيل المكان لا يفوت فأمكن اتخاذ الفعل فيه فلا يجب في غيره والزمان
يفوت فوجب القضاء في غيره
قلنا المكان أيضا ربما تعذر إيقاع الفعل فيه كما يتعذر بالزمان بأن يسبع
أو يعلوه الماء ثم إذا تعذر في المكان المعين لم يجب الفعل في غيره فكذلك
إذا تعذر في الزمان
واحتجوا بقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
وهذه الهاء كناية عن الصلاة المنسية فدل على أنه يجب قضاؤها
قلنا هو حجة لنا لأنه لو وجب القضاء بذلك الأمر لما احتاج إلى الأمر
بقضائها
واحتجوا بأن أوامر الشرع كلها يجب قضاؤها فدل على أن ذلك بمقتضى الأمر
والجواب هو أن كثيرا منها لا يدخلها القضاء فليس تعلقهم بما يقضى بأولى من
تعلقنا بما لا يقضى
وعلى أن القضاء فيما يجب قضاؤه إنما يجب بالأدلة التي هي قامت عليه لا
بموجب الأمر
قالوا ولأن الأمر موضوع لإيجاب الفعل وإسقاط القضاء يسقط إيجاب
الفعل
والجواب هو أن الأمر يقتضي إيجاب الفعل في وقت مخصوص لا في جميع الأوقات
ولأن هذا يبطل به إذا علقه على الشرط فإنه لا يجب فعله مع عدم الشرط وإن
كان مقتضى الأمر الإيجاب
واحتجوا بأن المأمور به هو الفعل وأما الوقت فإنما يراد لإيقاع الفعل فلم
يسقط بفواته
والجواب هو أن المأمور به هو الفعل في وقت مخصوص لا فعلا على الإطلاق ألا
ترى أن لفظه لا يتناول ما بعد الوقت فمن ادعى الوجوب فيه احتاج إلى دليل
واحتجوا بأنه لا خلاف أن ذلك يسمى قضاء ولو كان ذلك فرضا آخر يجب بأمر ثان
لما سمي قضاء لما تركه
قلنا إنما سمي قضاء لما تركه لأنه قام مقام المتروك لا أنه يجب بأمره
مسألة 12
الصوم واجب على المريض والمسافر والحائض في حال المرض والسفر والحيض وما يأتون به عند زوال العذر فهو قضاء لما وجب عليهم في حال العذروقال أهل العراق لا يجب على الحائض والمريض ويجب على المسافر
وقالت الأشعرية لا يجب على المريض والحائض وأما المسافر فعليه صوم أحد الشهرين إما شهر الأداء وإما شهر القضاء وأيهما صام كان أصلا كالأنواع الثلاثة في كفارة اليمين
لنا قوله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
ومعناه فأفطر فعدة من أيام أخر فدل على أن الفطر أوجب عليه ذلك
ولأنه لو لم يجب عليه ذلك لما وجبت عليه إلا إذا تكرر وقت مثله كالصلاة في
حال الحيض ولما ثبت أنها تخاطب بالقضاء عند زوال العذر دل على أن الوجوب
ثابت في حال الفطر
وأيضا هو أن ما يأتي به يسمى قضاء وهذا يدل على أنه بدل عنه
وأيضا فإنه ينوي في القضاء أنه يقضي صوم رمضان فدل على أنه قضاء لما فاته
ولأنه مقدر بما تركه لا يزيد عليه ولا ينقص منه ولو لم يكن قضاء لما تركه
لما تقدر به كما أن الأنواع الثلاثة في كفارة اليمين لما لم يكن كل واحد
منها قضاء لما تركه لم يقدر به ولما نقدرها ها هنا بالمتروك دل
على أنه قضاء له ويدل عنه كغرامات المتلفات
واحتجوا بأنه لو كان واجبا لما جاز تركه كالصوم في حق غير المعذور ولما
ثبت جواز تركه دل على أنه غير واجب كصوم النفل
قلنا قد بينا الجواب في إيجاب الصلاة في أول الوقت
قالوا الحائض لا يصح منها فعل الصوم ولا التوصل إلى فعله فلم يجز أن تكون
من أهل الوجوب
قلنا ينكسر بالمحدث فإنه لا يمكنه فعل الصلاة قبل الطهارة ثم هو من أهل
وجوبها فبطل ما قالوه
مسألة 13
إذا أمر بشيئين أو بثلاثة أشياء وخير فيها كان الواجب منها واحدا غير معينوقالت المعتزلة الجميع واجب
لنا أنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها ولو كان
الجميع واجبا لعوقب على الكل ألا ترى أن الصلوات الخمس لما كانت واجبة
عوقب على ترك الجميع
فإن قيل إنما عوقب على الجميع فيما ذكرتم لأن الجميع واجب على طريق الجمع
وليس كذلك هاهنا فإن الجميع واجب على طريق التخيير فلم يستحق العقوبة على
الجميع
قلنا لو كان الجميع واجبا لاستحق العقوبة على الجميع وإن لم يكن على سبيل
الجمع
ألا ترى أن فرض الكفاية لما كان واجبا على الكافة استحق الكل العقوبة على
تركه وإن لم يلزمهم ذلك على سبيل الجمع
وأيضا فإن التخيير ثبت بمرة بعموم اللفظ ومرة بخصوصه والنص عليه ثم ثبت أن
الثابت بالعموم لا يوجب جميع ما هو مخير فيه وهو إذا قال اقتل رجلا من
المشركين وأعتق رقبة وهو يقدر على رجال كثير ورقاب كثيرة كذلك الثابت
بالصريح والنص لا يوجب ما هو مخير فيه
واحتجوا بأنه لا مزية لبعضها على بعض فوجب أن يستوي الجميع في الوجوب كما
لو أمر بفعل الجميع من غير تخيير
والجواب هو أن استواء الجميع لا يوجب استواء الوجوب ألا ترى أنه لم يوجب
استواءه في العقاب فكذلك لا يوجب استواءه في الوجوب
ويخالف هذا ما أمر بفعله من غير تخيير فإن هناك لما وجب الجميع عوقب على
ترك الجميع
وفي مسألتنا لما لم يعاقب على ترك الجميع لم يجب الجميع
ولأن استواء الجميع على وجه التخيير مخالف لاستوائه على وجه الجمع
ألا ترى أنه ما وجب الجمع فيه بلفظ العموم يجب الجمع وهو إذا قال
اقتلوا المشركين وما يجب على وجه التخيير فيه بلفظ العموم لا
يجب الجمع وهو إذا قال اقتل رجلا من المشركين فدل على الفرق بينهما
واحتجوا أيضا بأنه لو كان الواجب واحد منها لعين وبين ولنصب عليه دليلا
وجعل إليه سبيلا وميزه من بين الجميع فلم يجعل ذلك إلى اختيار المكلف إذ
المكلف لا يعرف ما فيه المصلحة مما فيه المفسدة
والجواب أن هذا يبطل بما خيره فيه بلفظ العموم فإنه لم ينصب عليه دليلا
ولم يميزه بل جعله إلى اختيار المكلف ثم لم يكن الجميع واجبا
ثم هذا يبطل بالعقاب فإنه لا يستحق إلا على واحد غير معين ولم يميزه ولم
يجعل إليه سبيلا وما استحق عليه العقوبة يجب أن يكون معلوما معينا
ولأنه إنما يجب البيان إذا كان الوجوب متعلقا بمعين غير مبين
وأما إذا كان متعلقا بغير معين لم يجب البيان لأن المصلحة في الجميع
موجودة فترك البيان فيه لا يؤدي إلى أن يتخطى المصلحة ويتعداها
واحتجوا أيضا بأن فروض الكفايات تجب على الكافة ثم بفعل بعضهم تسقط عن
الباقين فكذلك الكفارات الثلاث يجب الجميع وبفعل بعضها يسقط الجميع
والجواب أن فرض الكفايات حجة عليهم فإنه لما وجب على الكافة خوطب الجميع
بفعلها وعوقب الجميع على تركها فلو كان في مسألتنا يجب الجميع لخوطب بفعل
الجميع وعوقب على ترك الجميع
وجواب آخر وهو أنه إنما وجب فرض الكفايات على الجميع لأنه لو لم يجب عليهم
لعول بعضهم على بعض فكان يؤدي إلى ترك الفعل وفي مسألتنا إيجاب واحد منها
لا يؤدي إلى ترك الواجب لأنه يعلم أن فرضه لا يسقط بفعل غيره فلا معنى
لإيجاب الجميع
مسألة 14
لا يدخل الآمر في الأمرومن أصحابنا من قال يدخل النبي صلى الله عليه و سلم فيما أمر به أمته
لنا أنه استدعاء للفعل فلا يدخل المستدعي فيه كالسؤال والطلب ولأن الأمر في اللغة استدعاء للفعل بالقول ممن هو دونه وهذه الحقيقة لا توجد في حق الآمر لأنه لا يجوز أن يكون دون نفسه
وأيضا فإنا لا نعلم خلافا بين علماء أهل اللسان أن السيد إذا أمر عبده فقال اسقني ماء لا يدخل هو في هذا الأمر فكذلك النبي صلى الله عليه و سلم مثله
ولأنه لو جاز دخوله مع غيره لجاز أن يدخل في أمره لنفسه وحده
وهو أن يقول افعل كذا ولما ثبت أنه لا يجوز أن يخص نفسه بالأمر فيكون أمرا
ومأمورا كذلك لا يجوز أن يدخل في عموم الأمر
ولأن المأمور لا يجوز أن يكون آمرا فكذلك الآمر لا يجوز أن يكون مأمورا
واحتجوا بأن أمر النبي صلى الله عليه و سلم يتضمن الإخبار عن وجوبه في
الشرع فصار بمنزلة ما لو قال هذه العبادة واجبة
والجواب أنه يتضمن الإخبار عن وجوبه على غيره وأما الوجوب على الإطلاق فلا
وأما الأصل فلا يسلم وإن سلمنا كان المعنى فيه أن قوله هذه العبادة واجبة
إيجابا مطلقا فاقتضى العموم وفي مسألتنا إيجاب خاص للمخاطبين فوزانه من
مسألتنا أن يقول فرضت عليكم وأوجبت عليكم فلا يدخل هو فيه
وجواب آخر وهو أن نقول إن الإخبار عن نفسه وحده يجوز كما لو قال كتب علي
ولم يكتب عليكم وفي مسألتنا لا يجوز أن يأمر نفسه وحدها كذلك لا يجوز أن
يأمرها مع غيرها
ولأن في الخبر لا تعتبر الرتبة وفي الأمر تعتبر الرتبة وذلك لا يوجب في
نفسه
مسألة 15
يدخل العبيد في مطلق أمر صاحب الشرعوقال بعض أصحابنا لا يدخلون فيه إلا بدليل
لنا صلاح الخطاب لهم كصلاحيته للأحرار فإذا دخل الأحرار فيه دخل العبيد فيه
ولأنه مكلف فجاز أن يدخل في الأمر المطلق كالحر
ولأنه يدخل في الخطاب الخاص له فدخل في الأمر العام كالحر
واحتجوا بأنهم لا يدخلون في أكثر الأوامر في الشرع كالجمعة والحج والجهاد فدل على أن إطلاق الخطاب لا يتناولهم
والجواب أن ما دخلوا فيه من الخطاب أكثر
ألا ترى أنهم دخلوا في الأمر بسائر الصلوات ودخلوا في الأمر
بالصوم وغير ذلك
ولأن ما لم يدخلوا فيه إنما لم يدخلوا فيه لأدلة دلت على تخصيصهم وكلامنا
في الأمر المجرد
واحتجوا بأن منافعهم مستحقة للموالي فلا يجوز أن يكونوا داخلين في الأمر
والجواب أنه يبطل به إذا خصهم بالأمر فإنهم يدخلون فيه مع وجود هذا المعنى
فبطل ما قالوه
ولأن أوقات العبادات تقع مستثناة فلا تكون منافعهم فيها مستحقة
مسألة 16
لا يدخل النساء في خطاب الرجالوقال ابن داود يدخلن في جمع الرجال وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة
لنا ما روي عن أم سلمة أن النساء قلن يا رسول الله ما نرى الله تعالى يذكر إلا الرجال فأنزل الله تعالى إن المسلمين والمسلمات الآية
وروي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ويل للذين يمسون فروجهم
ثم يصلون ولا يتوضؤون فقالت عائشة رضي الله عنها هذا للرجال أرأيت النساء
وهذا يدل على أن إطلاق خطاب الرجال لا يدخل فيه النساء
فإن قيل المراد به أنه لم يذكر النساء بلفظ يخصهن
قلنا هذا خلاف الظاهر فإن الخبر يقتضي أنهن لم يذكرن لا بلفظ الخصوص ولا
بلفظ العموم
ولأنه لو كان المراد به ما ذكره لم يختص النساء بذلك فإن الرجال ما ذكروا
بلفظ الخصوص فإن لفظ الذكور مشترك عندهم بين الرجال والنساء
ولأن حديث عائشة رضي الله عنها لا يحتمل ما ذكروه فإنه لو كان النساء
يدخلن في خطاب الرجال على سبيل العموم لما استفهمت منه حكم النساء بعد ذلك
وأيضا هو أنه موضوع للذكور فلا يدخل فيه الإناث كلفظ الواحد
ولأن أهل اللسان فرقوا بينهما في اسم الجمع كما فرقوا بينهما في اسم
الواحد وإذا لم يدخلن في اسم الواحد لم يدخلن في اسم الجمع
ولأن الرجال لا يدخلون في جمع النساء وكذلك النساء يجب أن لا يدخلن في جمع
الرجال
واحتجوا بأنهن يدخلن في أوامر الشرع كلها فدل على أن إطلاق الخطاب
يتناولهن
والجواب هو أنا لا نقول إنهن يدخلن في لفظ الأمر وإنما نقول شاركن الرجال
في الحكم بدليل قام عليه
قالوا وأيضا هو أن من أراد الجمع بين الرجال والنساء عبر عنهن
بعبارة الرجال فدل على أن لفظ الجمع موضوع للجميع
قلنا نحن إنما نحمل اللفظ على النساء إذا علم من قصد المتكلم أنه أراد
الجنسين وأما إذا لم يعلم هذا من قصده حملنا اللفظ على الرجال كما تقول في
الحمار إنه يحمل على الرجل البليد إذا علم هذا المراد من قصد المتكلم فأما
إذا لم يعلم من قصده حملنا اللفظ على البهيمة المخصوصة
فإن قيل لو لم يكن هذا اللفظ متناولا للجنسين لكان لا يجوز تغليب الذكور
عند إرادة الجنسين
قلنا هذا يبطل بما ذكرناه من قولهم في البليد حمار فإنه يعبر به عن البليد
مع القصد ثم إطلاق اللفظ لا يقتضيه
مسألة 17
الكفار مخاطبون بالشرعيات في قول أكثر أصحابناوقال بعضهم لا يدخلون في الخطاب بالشرعيات وهو اختيار الشيخ أبي حامد رحمه الله
وقال بعض الناس هم مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات
لنا قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم
المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وهذا يدل على أنهم مخاطبون بالصلاة والزكاة
إذ لو لم يكونوا مخاطبين بها لما حسن عقوبتهم على ذلك
فإن قيل المراد بذلك لم نكن من معتقدي الصلاة والزكاة
قيل هذا خلاف الظاهر فإن اللفظ حقيقة في فعل الصلاة وفعل الإطعام ولا يحمل
على الاعتقاد من غير دليل
ولأن العقوبة على ترك الاعتقاد قد علم من قوله وكنا نكذب بيوم الدين فيجب
أن يحمل الأول على غيره
فإن قيل الظاهر يقتضي استحقاق العقوبة بمجموع هذه الأشياء وهي ترك الصلاة
والزكاة والتكذيب بيوم الدين
قلنا لو لم يكن كل واحد منها يستحق العقوبة على تركها لما جمع بينهم في
استحقاق العقوبة
ولأن بالتكذيب بيوم الدين يستحق العقوبة من غير أن يضم إليه معنى آخر
وكذلك بترك الصلاة والزكاة يجب أن يستحق العقوبة من غير أن ينضم
إليه معنى آخر
ويدل عليه أنه لفظ مطلق فدخل الكفار فيه كالأمر بالإيمان
ولأن من تناوله الأمر بالإيمان تناوله الأمر بالعبادات كالمسلم ويدل عليه
هو أن المسلم إنما دخل في الأمر لصلاح اللفظ له في اللغة وهذا المعنى
موجود في الكافر فيجب أن يكون داخلا في الأمر ويدل عليه أنه ليس فيه أكثر
من الكفر وهو يقدر على إزالته ومن قدر على شرط الفرض كان مخاطبا بالفرض
كالمحدث إذا دخل عليه وقت الصلاة
فإن قيل الحدث لا ينافي صحة الصلاة ألا ترى صح أن المتيمم يصلي وهو محدث
وليس كذلك الكفر فإنه ينافي صحة الصلاة ألا ترى أنها لا تصح مع الكفر بحال
قلنا الحدث أيضا ينافي صحة الصلاة مع القدرة على الماء ثم هذا المعنى لا
يمنع من توجه الخطاب بفرض الصلاة فبطل ما قالوه
وأما ما يدل على فساد قول الطائفة الأخرى فنقول
النهي أمر بالترك والأمر أمر بالفعل فإذا دخل الكافر في أحد الأمرين دخل
في الأمر الآخر
فإن قيل الأمر بالترك لما دخل فيه تعلق عليه أحكامه من الحدود وغيرها ولما
لم يتعلق عليه أحكام الأمر بالفرض من صحة الفعل ووجوب القتل على تركها
والقضاء بفواتها دل على أنه لم يدخل في الأمر
قيل العقوبة على المخالفة ووجوب القضاء بالفوات ليس يتعلق بالأمر
بل يفتقر إلى أمر ثان وذلك لم يوجد فسقط وهذا لا ينفي الوجوب في
الابتداء كقضاء صلاة الجمعة يسقط عن المسافر لعدم الدليل على وجوبه ثم لم
يدل على أن الأمر بها لم يتوجه في الابتداء
فإن قيل النهي يصح منه امتثاله وهو الترك فدخل فيه الأمر والأمر لا يصح
منه امتثاله فلم يدخل في خطابه
قيل هذا يبطل بالأمر بالصلاة في حق المحدث فإنه لا يصح منه امتثاله ثم هو
داخل فيه
واحتجوا بأنه لو كان الكافر مخاطبا بالشرعيات لوجب أن يصح ذلك منه في حال
الكفر ولوجب عليه القضاء في حال الإسلام ولما لم يصح في الحال ولم يجب
القضاء في ثاني الحال دل على أنه غير مخاطب بها كالحائض في الصلاة
والجواب أنه إنما لم يصح منه لعدم الشرط وهو الإسلام وهذا لا ينفي توجه
الخطاب كالمحدث لا يصح منه فعل الصلاة ولا يدل على أنه غير مخاطب بها وأما
القضاء فإنما يجب بدليل غير الأمر وذلك لم يوجد فسقط وهذا لا ينفي الخطاب
في الابتداء كما قلنا في قضاء الجمعة تسقط عن المسافر لعدم الدليل ثم لا
يدل على أن الأمر بها لم يتوجه عليه
وأما الحائض فالمعنى فيها أنها لا تقدر على إزالة المانع وتحصيل الشرط
وليس كذلك الكافر فإنه يقدر على إزالة الكفر فهو كالمحدث في الصلاة
واحتجوا أيضا بأن خطابه بالعبادات خطاب بما لا منفعة له فيه والتكليف لا
يتوجه بما لا ينتفع به المكلف
والجواب هو أنا نخاطبه على وجه ينتفع به وهو أن يقدم الإيمان
ومتى دخل على هذا الوجه انتفع به فوجب أن يتوجه إليه الخطاب
قالوا ولأنه لو كان مخاطبا بفعل الصلاة معاقبا على تركها لعوقب على تركها
بالدنيا في القتل والضرب كسائر المسلمين
قلنا إنما لم يقتل ولم يضرب لأنه مجتهد في وجوب ذلك عليه ومع الاجتهاد لا
تجب العقوبة وليس كذلك المسلم فإن وجوب ذلك عليه غير مجتهد فيه فاستحق
العقوبة على الترك في الدارين
ثم هذا يبطل بأهل الذمة فإنهم مخاطبون بالإيمان معاقبون على تركه في
الآخرة ثم لا يعاقبون عليه في الدنيا
ويبطل بشربه الخمر فإن الذمي لا ينهى عنه ثم لا يحد
مسألة 18
الأمر بالشيء يدل على إجزاء المأمور بهوقال بعض المعتزلة لا يدل بل يفتقر إجزاؤه إلى دليل آخر
لنا هو أن الفعل إنما لزمه بالأمر فإذا فعل ذلك على حسب ما
يتناوله الأمر زال الأمر وعاد كما كان قبل الأمر ويدل عليه أنه لو نهي عن
فعل شيء فتركه ولم يتعرض له عاد كما كان قبل النهي فكذلك إذا أمر بفعل شيء
ففعله
واحتجوا بأن كثيرا من العبادات أمر الإنسان بفعلها ثم لم تجزئه كالمضي في
الحج الفاسد والإمساك في يوم ظن أنه في يوم من شعبان فبان أنه من رمضان
والصلاة بغير طهارة عند عدم الماء والتراب فدل على أن الإجزاء يقف على
دليل آخر
والجواب هو أن الذي أتى به المفسد للحج والممسك في رمضان والعادم للماء
والتراب بالأمر يجزئه عن ذلك الأمر وإنما لزمه القضاء بأمر ثان إذ لا يجوز
أن يؤمر بفعل شيء على صفة ثم لا يجزئه
وجواب آخر وهو أنه في تلك المواضع لم يأت بالمأمور على حسب ما تناوله
الأمر فبقي الفرض عليه وفي مسألتنا أتى بالمأمور على حسب ما اقتضاه الأمر
وتناوله فعاد كما كان قبل الأمر
قالوا وأيضا هو أن الأمر لا يدل على أكثر من الإيجاب وإرادة المأمور به
وأما الإجزاء وسقوط الفرض فلا يدل عليه اللفظ فافتقر ذلك إلى دليل آخر
والجواب هو أن الأمر لا يدل على ما ذكروه ولكنه يدل على أنه أراد فعل
المأمور به على الوجه الذي أمر به فدل على أن الأمر قد زال عنه وزوال
الأمر يوجب سقوط الفرض وأنه لا يجب عليه غيره إلا بدليل
مسألة 19
إذا فعل زيادة على ما تناوله الاسم من الفعل المأمور به مثل أن يزيد على ما يقع عليه اسم الركوع أو يزيد على ما يقع عليه اسم القراءة فالواجب منه ما يتناوله الاسم وما زاد عليه فهو نفلوقال بعض الناس كل ذلك واجب وحكى ذلك عن أبي الحسن الكرخي
لنا أن لفظ الأمر بالركوع لا يقتضي أكثر مما يسمى ركوعا فإذا فعل ذلك فقد فعل ما اقتضاه الأمر فوجب أن تكون الزيادة نفلا يدلك عليه هو أنه لما لم يقتض أكثر من مرة واحدة كان ما زاد على ذلك نفلا فكذلك ما زاد على قدر الفرض
ولأنه إذا فعل من ذلك ما يقع عليه الاسم حسن أن يخبر عن نفسه فيقول فعل كذا وكذا ولو كان اللفظ يقتضي أكثر من ذلك لما حسن الإخبار عن نفسه بالفعل كما لا يحسن إذا فعل ما لا يقع عليه الاسم
ولأن الزيادة على ما يقع عليه الاسم يجوز للمكلف تركها من غير بدل ومن غير أن يفعل مثها في وقت آخر وما هذا سبيله لم يكن واجبا كسائر النوافل
واحتجوا بأن الاسم يتناول أواخر الفعل كما يتناول أوائله فإذا
كانت الأوائل واجبة كانت الأواخر مثلها
قلنا لو كانت الأواخر كالأوائل لأثم بتركها كما أثم بترك الأوائل
قالوا ولأنه لو قال لوكيله تصدق من مالي جاز له أن يتصدق بالقليل منه
والكثير فدل على أن الأمر قد تعلق بالجميع
قلنا لا نسلم هذا بل لا يجوز أن يتصدق إلا بأدنى ما يتناوله الاسم وإن
سلمنا فالفرق بينهما أن الأمر منا إذا أراد التصدق بقدر معلوم بين ذلك
وقدره فلما لم يبين علمنا أنه أراد ما شاء المأمور وليس كذلك أوامر صاحب
الشرع لأنه لا عادة في أوامر الشرع فيراعى حكمها فلم تقتض إلا ما يقع عليه
الاسم
مسألة 20
الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى وقالت المعتزلة ليس هو بنهي عن ضده وهو قول بعض أصحابنا
لنا هو أنه لا يمكنه فعل المأمور به إلا بترك الضد فوجب أن يكون الأمر
يتضمن النهي عن ضده
ألا ترى أنه لما لم يمكنه فعل الصلاة إلا بما يتوصل به إليها كالطهارة
واستقبال القبلة واستقاء الماء وغير ذلك كان الأمر بالصلاة متضمنا للأمر
بكل ما يتوصل به إليها كذلك ههنا ويدل عليه هو أن الأمر بالشيء عندهم
يقتضي إرادة المأمور به وحسنه وإرادة الشيء وحسنه يقتضي كراهية ضده وقبحه
وذلك يقتضي تحريمه فيجب أن يكون الأمر بالشيء تحريما لضده
فإن قيل يبطل بالنوافل فإن الأمر بها يقتضي إرادتها وحسنها ثم لا يقتضي
ذلك كراهية الضد وقبحه
والجواب هو أنا ألزمناهم على أصلهم فلا يلزمنا ما توجه عليهم
وأما على مذهبنا فإن الأمر بالنوافل يقتضي استدعاء المأمور به وحسنه على
سبيل الاستحباب وهو يقتضي النهي عن ضدها على سبيل الاستحباب أيضا
ولأن السيد إذا قال لعبده قم فقعد حسن توبيخه ولومه ولو لم يكم الأمر
بالقيام اقتضى النهي عن ضده لما جاز توبيخه على القعود
واحتجوا بأن صيغة الأمر خلاف صيغة النهي فلا يجوز أن يكون لفظ أحدهما
مقتضيا للآخر
والجواب هو أن هذا إنما يمتنع لو قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق
اللفظ وأما إذا قلنا إنه نهي من طريق المعنى لم يمتنع
ألا ترى أن لفظ الأمر بالصلاة خلاف لفظ الأمر بالطهارة من طريق اللفظ ثم
الأمر بالصلاة يتضمن الأمر بالطهارة من طريق المعنى كذلك ههنا
قالوا الأمر والنهي متضادان كتضاد العلم والجهل ثم العلم بالشيء لا يكون
جهلا بضده كذلك الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده
قلنا العلم بالشيء لا ينافي العلم بضده والأمر بالشيء ينافي الأمر بضده
ألا ترى أنه يجوز أن يكون عالما بكل واحد منهما وليس كذلك الأمر فإنه
ينافي فعل ضده ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون فاعلا للمأمور به إلا بترك ضده
فدل على الفرق بينهما
واحتجوا بأن النهي عن الشيء ليس بأمر بضده وكذلك الأمر بالشيء ليس بنهي عن
ضده
والجواب أنا لا نسلم هذا بل هو أمر بضده فإن كان له ضد واحد فهو أمر به وإن كان له أضداد فهو أمر بضد من أضداده فلا فرق بينهما
مسألة 21
الأمر بفعل العبادة لا يقتضي فعلها على وجه مكروه ولا يدخل فيه كالطواف بغير طهارة لا يدخل في قوله وليطوفوا بالبيت العتيقوقال أصحاب أبي حنيفة يدخل فيه
لنا أن الأمر يقتضي الإيجاب والاستحباب والمكروه لا يجب ولا يستحب فمن المحال أن يكون داخلا في الأمر ويدل عليه أن المكروه منهي عن فعله فلا يدخل في لفظ الأمر كالمحرم
احتجوا بأن الأمر بالطواف لا يتناول أكثر من الجولان حول البيت فأما الطهارة فليس في اللفظ ما يقتضيها فإذا طاف بلا طهارة فقد فعل ما يقتضيه اللفظ فوجب أن يكون ممتثلا للأمر
قلنا اللفظ لا يتقضي الطهارة إلا أنهم أجمعوا على أن المراد به طواف بطهارة فإذا طاف بغير طهارة لم يفعل المأمور به فوجب أن لا يكون ممتثلا للأمر
مسألة 22
الفرض والواجب واحد وهو ما يعاقب على تركهوقال أصحاب أبي حنيفة الفرض أعلى رتبة من الواجب فالفرض ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به بكتاب أو سنة متواترة أو إجماع والواجب ما ثبت وجوبه بغير ذلك من الأدلة
لنا قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج وأراد به أوجب الحج
ولأنه لو كان الفرض ما ثبت بطريق مقطوع به لوجب أن تكون النوافل تسمى فرائضا لأنها تثبت أيضا بطريق مقطوع به
ولأن تخصيص الفرض بما ثبت بطريق مقطوع به دعوى لا دليل عليها من جهة الشرع ولا من جهة اللغة فكان باطلا
ولأن لفظ الوجوب في الإيجاب أكثر من لفظ الفرض لأن الفرض يحتمل من المعاني ما لا يحتمله الواجب ألا ترى أن الفرض مستعمل في التقدير ولهذا يقال فرض الحاكم نفقة المرأة إذا قدرها ويستعمل في الإنزال قال الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن أي أنزل ويستعمل في البيان كقوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها أي بيناها ويستعمل في فرض القوس وهو إذا حز طرفيه والواجب لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو سقوطه عليه من قولهم وجب الحائط ووجبت الشمس فإذا قيل هذا واجب كان معناه أنه سقط عليه سقوطا لا بد من فعله وكان ما قالوه بالعكس أولى
مسألة 23
إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز في أحد الوجهينومن أصحابنا من قال يجوز الاحتجاج به على ذلك
لنا هو أن اللفظ غير موضوع للجواز وإنما هو موضوع للوجوب والجواز تابع له يعلم من ضمنه من جهة الاستدلال وهو أنه لا يجوز أن يكون واجبا ولا يجوز فعله وإذا سقط الوجوب سقط ما في ضمنه من الجواز
واحتج من قال بالوجه الآخر بأن اللفظ يدل على الوجوب والجواز فإذا دل الدليل على سقوط أحدهما بقي الآخر كما تقول في العموم إذا خص منه بعض ما تناوله
قلنا العموم يتناول كل واحد من الجنس بلفظ فإذا خرج بعضه بدليل بقي الباقي وليس كذلك ههنا فإن اللفظ
الكف عن الفعل وترد والمراد بها التهديد على الترك والحث على
الفعل فوجب أن يتوقف فيها حتى يقوم الدليل على ما يراد به كما نقول في
الأسماء المشتركة كاللون والعين
قلنا اللفظ بإطلاقه موضوع للكف والإحجام وإنما يحمل على ما سواه من الفعل
والإقدام بضرب من الدليل من شاهد حال أو غيره كالبحر موضوع للماء المجتمع
وإن كان يستعمل في الرجل العالم والرجل السخي والفرس والجواد ويخالف ما
ذكروه من الأسماء المشتركة فإن تلك الأسماء لم توضع لشيء بعينه وهذا اللفظ
موضوع للكف
والذي يدل عليه هو أن أهل اللسان عولوا في الأسماء المشتركة على ما يقرن
بها من البيان من الوصف والإضافة وغيرهما وعولوا في النهي على مجرد الصيغة
ولهذا عاقب السيد عبده على التوقف ولا يعاقب فيما أتى به من الأسماء
المشتركة فدل على الفرق بينهما
مسألة 3
النهي يقتضي التحريموقالت الأشعرية لا يقتضي التحريم ويتوقف فيه إلى أن يرد الدليل
لنا هو أن الصحابة رضي الله عنهم رجعت في التحريم إلى مجرد النهي
روي عن ابن عمر أنه قال كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة فتركناها لقول رافع
ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده لا تفعل كذا فخالفه استحق التوبيخ والعقوبة فدل على أن إطلاقه يقتضي التحريم
واحتجوا بأن هذه الصيغة توجد ويراد بها التحريم وتوجد والمراد بها الكراهة فلا تحمل على واحد منهما إلا بدليل
والجواب أن هذا يبطل باسم البحر فإنه يرد والمراد به الماء الكثير المجتمع ويرد والمراد به الرجل السخي أو العالم ثم إطلاقه يحمل على الماء الكثير المجتمع فبطل ما قالوه
مسألة 4
النهي يقتضي فساد المنهي عنه في قول عامة أصحابناوقال أبو بكر القفال لا يقتضي الفساد وهو قول أبي الحسن
الكرخي من أصحاب أبي حنيفة ومذهب عامة المتكلمين
لنا قوله عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وروي من أدخل في
ديننا ما ليس منه فهو رد والمنهي عنه ليس عليه أمره فيجب أن يكون ردا
فإن قيل هذا من أخبار الآحاد فلا يجوز أن يستدل به على مسائل الأصول
قيل هو وإن كان من أخبار الآحاد إلا أنه متلقى بالقبول فهو كالمتواتر
ولأن هذا وإن كان من مسائل الأصول إلا أنها من مسائل الاجتهاد فهي بمنزلة
سائر الفروع
فإن قيل الرد ضد القبول وهو ما لا يثاب عليه ولهذا يقال هذا عمل مقبول
وهذا عمل مردود ولهذا يقال في دعاء شهر رمضان ليت شعري من المقبول منا
فنهنيه ومن المردود فنعزيه وكأنه قال من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو غير
مقبول ونحن نقول إن ذلك غير مقبول على معنى أنه لا يثاب عليه
قلنا الرد يستعمل في ضد القبول كما ذكروه ويستعمل في معنى الإبطال
والإفساد
ألا ترى أنك تقول رددت على فلان كذا إذا أفسدته وأبطلته ويقال في
بعض الكتب على المخالفين الرد على فلان وإذا كان اللفظ مستعملا
في الأمرين وجب أن يحمل اللفظ على الجميع
فإن قيل الذي ليس من ديننا هو الشيء المنهي عنه من الالتفات في الصلاة
والغيبة في الصوم وذلك عندنا مردود باطل والخلاف فيما يقع فيه المنهي عنه
كالصوم والصلاة وذلك من ديننا فلم يكن ردا
قلنا فعل العبادة على وجه النهي أيضا ليس من الدين ولهذا لا يثاب عليه ولا
يجوز فعلها فوجب أن يكون مردودا ويدل عليه هو أن الصحابة رضي الله عنهم
احتجوا في الإبطال بالنهي روي عن ابن عمر أنه قال نكاح المشركات باطل
لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن
وأيضا هو أن الأمر اقتضى اشتغال الذمة بعبادة متجردة عن النهي إذ لا يجوز
أن يكون المنهي عنه هو الذي ورد الأمر به فإذا فعل على الوجه المنهي عنه
لم يأت بالمأمور به وإنما أتى بغيره فبقي الفرض في ذمته كما كان وصار
بمنزلة ما لو أمر بفعل الصلاة فأتى بالصوم
ولأن الحكم بصحة العبادة وإجزائها للأمر المنهي عنه لم يتعلق به الأمر فلم
يجز أن يحكم له بالصحة
واحتجوا بأن النهي يقتضي قبح المنهي عنه وقبحه لا يدل على بطلانه كالطلاق
في حال الحيض والوضوء بالماء المغصوب
والجواب هو أن النهي يقتضي معنى يدل على القبح وهو أن ما يفعله غير ما ورد
به الشرع وذلك يوجب بطلانه على ما بيناه
وأما الطلاق في حال الحيض والوضوء بالماء المغصوب فإنما حكمنا بصحتها
لقيام الدلالة عليه وليس إذا ترك ظاهر اللفظ في بعض المواضع
لقيام الدليل دل على بطلان مقتضاه ويجب أن يترك في كل موضع
ألا ترى أن النهي قد يرد في بعض المواضع ولا يراد به التحريم ثم لا يدل
ذلك على أن إطلاقه لا يقتضي التحريم
قالوا لو كان النهي يقتضي فساد المنهي عنه لوجب إذا تناول ما ليس بفاسد أن
يكون مجازا ولما وجدنا النهي على سبيل الحقيقة في كثير من المواضع ولا
يقتضي الفساد دل على أنه لا يقتضي ذلك
والجواب أنا لا نقول إنه مجاز لأن المجاز ما نقل عن جميع موجبه وهو ها هنا
لم ينقل عن جميع موجبه بل حمل على بعض موجبه وذلك أن النهي يقتضي التحريم
وفساد المنهي عنه فإذا دل الدليل على أنه غير فاسد بقي حقيقة في الباقي
كالعموم إذا خص بعضه
قالوا ولأنه ليس في اللفظ ما يوجب إعادة الفعل فمن ادعى وجوب الإعادة
احتاج إلى دليل
والجواب أن الذي دل على وجوب الإعادة هو الأمر بالفعل وذلك أن الأمر
يتناول عبادة لا يتعلق بها نهي وهو لم يفعل ذلك فكان الأمر بإيجاب الفعل
باقيا كما كان
قالوا ولأنه ليس في فعله على وجه النهي أكثر من فعله منهيا عنه وقولكم إنه
فاسد زيادة صفة يحتاج في إثباته إلى دليل
قلنا معنى قولنا فاسد أنه لا يعتد به عما تعلق الأمر عليه وليس يحتاج في
ذلك إلى دليل أكثر مما يتناوله وهو أنه لم يفعل المأمور به فيجب أن يكون
المأمور به باقيا في الذمة
مسألة 5
وإذا نهى عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز فعل أحدهماوقالت المعتزلة يكون نهيا عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما
لنا أنه أمر بترك أحدهما فلا يجب تركهما كما لو أمر بفعل أحدهما لم يجب فعلهما
واحتجوا بأن ما كان منهيا عنه مع غيره كان منهيا عنه بانفراده كسائر المحظورات
قلنا هذا يبطل بنكاح إحدى الأختين فإنه منهي عنه مع نكاح أختها وليس بمنهي عنه عند الانفراد
قالوا ولأن أو فى النهي يقتضي الجمع والدليل عليه قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا والمراد به وكفورا
قلنا لا نسلم ما ذكروه من الآية وإنما حملنا على ما ذكروه بدليل
مسائل العموم والخصوص
مسألة 1
للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقةوقالت الأشعرية ليس للعموم صيغة وما يرد من ألفاظ الجمع فلا يحمل على العموم ولا على الخصوص إلا بدليل
ومن الناس من قال إن كان ذلك في الأخبار فلا صيغة له وإن كان ذلك في الأمر والنهي فله صيغة تحمل على الجنس
وقال بعض المتكلمين تحمل ألفاظ الجمع على أقل الجمع ويتوقف فيما
زاد وهو قول أبي هاشم ومحمد بن شجاع الثلجي
لنا قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من
أهلي وإن وعدك الحق فحكى الله تعالى عن نوح أنه تعلق بعموم اللفظ ولم يعقب
ذلك بنكير بل ذكر أنه أجاب بأنه ليس من أهله فقال إنه ليس من أهلك إنه عمل
غير صالح فدل على أن مقتضى اللفظ العموم
وأيضا ما روى أنه لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب
جهنم أنتم لها واردون قال عبد الله بن الزبعرى لأخصمن محمدا فجاء إلى رسول
الله صلى الله عليه و سلم فقال قد عبدت الملائكة وعبد المسيح أفيدخلون
النار فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون
فاحتج على النبي صلى الله عليه و سلم بعموم اللفظ ولو لم يقتض اللفظ
العموم لما احتج به ولأنكر النبي عليه احتجاجه
فإن قيل إنما تعلق باللفظ فيما ذكرتم لأن اللفظ يصلح للعموم
قلنا لو كان لصلاح اللفظ لكان لا يقطع بأنه يخصم محمدا عليه السلام لأنه
بالصلاح لا يمكنه أن يخصم
وأيضا إجماع الصحابة رضي الله عنهم روى أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر
الصديق رضي الله عنه في مانعي الزكاة كيف تقاتلهم وقد قال النبي عليه
السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاحتج بعموم اللفظ
ولم ينكر عليه أبو بكر ولا أحد من الصحابة بل عدل أبو بكر في الجواب إلى
الاستثناء المذكور في الخبر وهو قوله إلا بحقها وإن الزكاة من حقها
وروى ابن عمر وعليا عليهما السلام قالا في الجمع بين الأختين بملك اليمين
أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى فحملا اللفظين على العموم ثم رجحا
لفظ التحريم
وروى أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أنشد ... ألا كل شيء ما خلا الله
باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل ...
فقال كذب فإن نعيم أهل الجنة لا يزول ولو لم يكن قول الشاعر اقتضى العموم
لما جاز تكذيبه
فإن قيل هذه أخبار الآحاد فلا يحتج بها في مسائل الأصول
قلنا وإن كانت من أخبار الآحاد إلا أن الأمة أجمعت على قبولها وإن اختلفت
في العمل بها فصارت مقطوعا بصحتها
ويدل عليه هو أن العرب وضعت للواحد صيغة وللاثنين صيغة وللثلاثة صيغة
فقالوا رجل ورجلان ورجال وفرقت بينها كما فرقت بين الأعيان في الاسم
فقالوا فرس وحمار وبغل فلو كان احتمال لفظ للاثنين كاحتماله لما زاد لم
يكن لهذا التفريق في الوضع معنى
وأيضا هو أنه يصح أن يستثنى من ألفاظ الجمع كل واحد من الجنس فتقول رأيت
الناس إلا زيدا وإلا عمرا ولو لم يقتض اللفظ جميع الجنس لم يصح الاستثناء
لأن الاستثناء يخرج من اللفظ ما لولاه لدخل فيه ولهذا لا يصح أن تستثنى
البهائم من الناس حين لم يدخل في اللفظ
فإن قيل إنما حسن الاستثناء لصلاح اللفظ لكل واحد من الجنس
قيل هذا لا يصح لأن الاستثناء لا يخرج إلا ما اقتضاه اللفظ فإنه مأخوذ من
قولهم ثنيت عنان الدابة إذ صرفته وقيل إنه يسمى بذلك لأنه تثنية الخبر بعد
الخبر وأيهما كان اقتضى دخول المستثنى في اللفظ حين نصرفه عنه في قول
بعضهم وثنى الخبر بعد الخبر في قول البعض
ولأنه لو كان حسن الاستثناء لجواز أن يكون دخلا في اللفظ لوجب أن يصح من
النكرات كما يصح من المعارف المقتضية للجنس فلما لم يحسن ذلك في النكرات
دل على بطلان ما ذكروه
وأيضا هو أنه إذا قال لرجل من عندك حسن أن يجيب بكل واحد من
جنس العقلاء ولو لم يكن اللفظ عاما في الجنس لما صار مجيبا بكل
واحد من الجنس لجواز أن يكون المسؤول عنه غير الذي أجاب به
فإن قيل إنما حسن أن يجيب بكل واحد من الجنس لأن اللفظ يصلح لكل واحد منهم
قيل اللفظ يصلح لمن أجاب به ولغيره فيجب أن لا يصح الجواب حتى يعلم مراد
السائل ويدل عليه أنه لو قال من دخل الدار فله درهم أو من رد عبدي الآبق
فله درهم استحق كل من وجد ذلك منه العطاء فدل على أن اللفظ يقتضي الكل
وأيضا هو أن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه وتعم البلوى به في
مصالح الدين والدنيا فيجب أن يكون وضع له لفظ يدل عليه كما وضعوا لسائر ما
دعت الحاجة إلى العبارة عنه من الأعيان وغيرها
فإن قيل فقد وضع له ما يدل عليه وهو التأكيد
قيل إذا سلمتم أن ألفاظ التأكيد تدل على العموم فقد سلمتم المسألة لأن
التأكيد لا يدل إلا على ما يدل عليه المؤكد ولا يفيد إلا ما أفاده فإذا
كان لفظ التأكيد يقتضي العموم دل على أن المؤكد اقتضاه
فإن قيل نعلم العموم بالأحوال والعادات فيستغني بها عن لفظ يوضع له
قيل هذا لا يصح لأن هذا يختص بمن بيننا وبينه عادة في الخطاب فأما من جهة
الله تعالى فلا يمكن معرفة العموم إذ لا عادة بيننا وبينه وكذلك لا يمكن
معرفة ذلك فيما ينقل إلينا من الأخبار لأنها لا تنقل مع أحوالها ولا عادة
بيننا وبين المتكلم فيما ينقل إلينا
فإن قيل هذا يبطل بالطعوم والروائح فإن الحاجة ماسة إلى تمييزها والعبارة
عنها ثم لم يضعوا لكل واحد منها عبارة تدل عليه
قيل قد وضعوا لذلك ما يدل عليه وهو الإضافة فقالوا طعم الشهد
وطعم السفرجل وطعم الخبز وطعم الماء وحلاوة السكر وحلاوة العسل
ورائحة المسك ورائحة الكافور وغير ذلك
فأما من فرق بين الأخبار وبين الأمر والنهي فلا وجه لقوله لأن ما وضع
للعموم في اللفظ لم يختلف فيه الخبر والأمر والنهي
ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول من دخل الدار فأكرمه وبين أن يقول من دخل
الدار أكرمته وإن كان أحدهما أمرا والآخر خبرا فدل على فساد ما قالوه
واحتجوا بأنه لا يخلو إثبات صيغة العموم من أن يكون بالعقل أو بالنقل
ولا يجوز إثباتها بالعقل لأنه لا مجال له في إثبات اللغات
ولا يجوز أن يكون بالنقل لأن النقل تواتر وآحاد ولا تواتر فيه لأنه لو كان
لعلمناه كما علمتم والآحاد لا يقبل في مسائل الأصول فبطل إثباتها
قلنا هذا ينقلب عليكم في إثبات الاشتراك بين الخصوص والعموم في هذه
الألفاظ فإنه لا يخلو من أن يكون بالعقل ولا مجال له فيه أو بالنقل والنقل
تواتر وآحاد ولا تواتر فيه لأنه لو كان لعلمناه كما علمتم والآحاد لا يقبل
في إثبات اللغة
وعلى أنا قد بينا ذلك بطرق من جهة النقل تجري مجرى التواتر وقد بيناها
فأغنى عن الإعادة
قالوا ولأن هذه الألفاظ ترد والمراد بها البعض وترد والمراد بها الكل فلم
يكن حملها على أحدهما بأولى من الآخر فوجب التوقف فيها كما تقول في
الأسماء المشتركة من اللون والعين وغيرها
قلنا لا يمنع أن يستعمل اللفظ فيهما ثم هو حقيقة في أحدهما دون الآخر
كالحمار يستعمل في الرجل البليد ويستعمل في البهيمة المعروفة ثم
هو حقيقة في البهيمة وكذلك البحر يستعمل في الرجل الجواد وفي الماء
المجتمع الكثير ثم هو حقيقة في الماء المجتمع
قالوا ولأن هذه الألفاظ لا تستعمل في أكثر المواضع إلا في البعض دون الكل
ألا ترى أنه يقال أغلق الناس وفتح الناس وافتقر الناس وجمع السلطان التجار
والمراد في ذلك كله البعض ولو كان اللفظ حقيقة في العموم لكان أكثر كلام
الناس مجازا
قلنا يجوز أن يكون اللفظ حقيقة في معنى ثم يستعمل في غيره
ألا ترى أن الغائط حقيقة في الموضع المطمئن من الأرض ثم يستعمل أكثر في
الخارج من الإنسان وكذلك الشجاع حقيقة في الحية ثم أكثر ما يستعمل في
الرجل البطل فبطل ما قالوه
قالوا ولأنه لو كان اللفظ حقيقة في الجنس لما حسن فيه الاستفهام فتقول
أردت به الكل كما لا يحسن في الأعداد كالعشرة وغيرها
قلنا حسن الاستفهام لا يدل على أن اللفظ ليس بحقيقة في شيء بعينه
ألا ترى أنه إذا قال رأيت بحرا حسن فيه الاستفهام بأن تقول رأيت ماء كثيرا
أو رجلا جوادا ثم هو حقيقة في الماء الكثير وكذلك إذا قال أعط فلانا مائة
ألف حسن أن يستفهم فيقول مائة ألف درهم ولا يدل على أن ذلك ليس بحقيقة فيه
ولأنه إنما حسن الاستفهام لأن اللفظ يحتمل العموم وغيره فجاز أن يستفهم
ليزول الاحتمال
قالوا ولأنه لو كانت هذه الألفاظ حقيقة في الجنس لوجب إذا دل الدليل على
أنه أراد به البعض أن يصير مجازا لأنه يستعمل في غير ما وضع له
قلنا المجاز ما تجوز به عما وضع له كالحمار حقيقة في البهيمة ثم
يتجوز به في الرجل البليد فيكون مجازا فيه وأما لفظ العموم فما تجوز به
عما وضع له وإنما حمل على بعض ما يقتضيه فلم يصر مجازا فيما تبقى كما لو
قال علي عشرة إلا خمسة
قالوا ولأنه لو كان اللفظ يقتضي استغراق الجنس لوجب أن يكون تخصيص بعضه
يوجب كذب المتكلم به كما إذا قال رأيت عشرة ثم بان أنه رأى خمسة عد كاذبا
قلنا هذا يبطل به إذا قال أقبل عشرة أنفس ثم خص بعضهم فإن اللفظ تناول
العشرة ثم تخصيصه لا يوجب الكذب
ولأن على قول من قال من أصحابنا تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز له
لأنه يؤدي إلى الكذب لأنه يكون مقارنا للفظ فيصير كالاستثناء مع المستثنى
منه وعلى قول من أجاز تأخير البيان لا يلزم لأن الصدق والكذب إنما هو في
الأخبار وعلى قول أصحابنا لا يجوز تخصيص الأخبار وإنما يجوز تخصيص الأمر
والنهي والصدق والكذب لا يدخلان في ذلك فإذا خص شيء منه كان نسخا له ومن
أصحابنا من أجاز تخصيص الأخبار فعلى هذا أيضا لا يؤدي إلى الكذب لأم كلام
صاحب الشرع وإن تأخر بعضه عن بعض كالاستثناء مع المستثنى منه فلا يؤدي إلى
ما ذكروه ولهذا يطلق الأمر في الشرع ثم يرد ما يسقطه وهو النسخ ولا يعد
ذلك بداء ولو كان في غير ألفاظ صاحب الشرع أو ورد مثل هذا عد بداء
قالوا ولأنه لو كان هذا اللفظ موضوعا للعموم لما جاز تخصيصه من الكتاب
بالسنة والقياس لأنه إسقاط ما ثبت بالقرآن وذلك لا يجوز بالسنة والقياس
كما لا يجوز النسخ بهما
قلنا النسخ إسقاط اللفظ فلم يجز إلا بمثله أو بما هو أقوى منه
والتخصيص بيان حكم اللفظ فجاز بما دونه
قالوا ولأنه لو كان اللفظ يقتضي الجنس لكان لا يوجد إلا وهو يقتضيه كما أن
العلة لما كانت مقتضية للحكم لم يجز وجودها إلا وهي مقتضية له
قلنا هذا الدليل إنما يصح لو لم يجز استعمال اللفظ في غير ما وضع له فأما
إذا جاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لم يكن وجود الصيغة غير مقتضية
للعموم دليلا على أن الصيغة غير موضوعة للعموم
ولأنه لو جاز أن يقال هذا لوجب أن يقال إن الحمار ليس بموضوع للبهيمة
المخصوصة لأنه قد يستعمل في غير البهيمة وهو الرجل البليد وفي إجماعنا على
فساد هذا دليل على بطلان ما ذكروه على أن اللفظ المقتضي للاستغراق هو
الصيغة المجردة عن القرينة وذلك لا يجوز أن يوجد إلا وهي تقتضي الجنس كما
لا يجوز أن توجد العلة ألا وهي تقتضي الحكم فأما ما اقترن به قرينة
التخصيص فغير مقتضية للجنس فهي بمنزلة وجود العلة يجوز وجوده غير مقتض
للحكم
واحتج من حمل اللفظ على الثلاثة ووقف فيما زاد بأن الثلاثة أقل الجمع
فحملنا اللفظ عليه وما زاد مشكوك فيه فلا يحمل اللفظ عليه من غير دليل
الجواب أن قولهم إن الثلاثة أقل الجمع مسلم وأن ما زاد عليه مشكوك فيه
دعوى تحتاج إلى دليل على أن الذي اقتضى حمل اللفظ على الثلاثة يقتضي حمله
على ما زاد وذلك أن اللفظ موضوع للثلاثة ولما زاد عليه لا يختص ببعض
الأعداد دون بعض فوجب حمله على الجميع
ولأنه لو جاز أن يقتصر على ثلاثة لأنه متيقن لوجب أن يقال في أسماء
الأعداد كالعشرات والمائين إنها تحمل على ثلاثة لأنها متيقنة ويتوقف في
الزيادة وهذا لا يقوله أحد فبطل ما قالوه
قالوا ولأنه لو كان لفظ الجمع يقتضي العموم لوجب إذا قال لفلان
علي دراهم أن لا يقبل منه ثلاثة
الجواب أن قوله لفلان علي دراهم نكرة ومثل هذا لا يقتضي عندنا الجنس وإنما
الذي يقتضي الجنس إذا تعرف بالألف واللام
على أنا لم نحمل ذلك على الجنس في الإقرار بدليل دل عليه وهو أنه يعلم
بطريق العرف والعادة أنه لا يجوز أن يكون مراده جنس الدراهم إذ لا يجوز أن
يكون قد أتلف عليه كل درهم في الأرض واستقرض ذلك منه فلم يحمل على العموم
لدلالة العرف وليس إذا لم يحمل اللفظ على مقتضاه لدلالة اقترنت به لم يحمل
على مقتضاه فيما لم تقترن به دلالة وقد قيل إن الإقرار إنما لم يحمل على
الجنس لأنه قام عليه دليل أنه لم يرد به الجنس وهو التمييز فوزانه في
مسألتنا أن يرد له لفظ العموم ثم نقول الدلالة على الخصوص فيحمل عليه
وهاهنا تجرد اللفظ عن الدلالة فهو كما لو أقر بالدراهم ولم يحلف فيحمل
اللفظ على ما يدعيه المدعي من قليل وكثير
مسألة 2
الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهو للجنس والطبقةومن أصحابنا من قال هو للعهد وهو قول أبي يحيى الحباني
لنا أن الألف واللام لا يدخل على الاسم إلا للجنس ولهذا قال
الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره وقال خلق الإنسان ضعيفا وحملها الإنسان
إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى وأراد في هذا كله
الجنس ويقال أهلك الناس الدينار والدرهم وملك الشاء والبعير ويراد به
الجنس فدل على أنه موضوع له
ولأنه يحسن فيه الاستثناء بلفظ الجمع كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاقتضى الجنس كأسماء الجموع
ولأنه لو دخل الألف واللام على أسماء الجموع كالمسلمين والمشركين اقتضى
الجنس فكذلك إذا دخل على الاسم المفرد
ولأنه لو كان يقتضي العهد لوجب أن لا يصح الابتداء به حتى يتقدم بين
المخاطب والمخاطب معهود يرجع اللفظ إليه ولما رأينا ذلك مستعملا في خطاب
الله تعالى وليس بيننا وبينه عهد متقدم يرجع اللفظ إليه دل على أنه لا
يقتضي المعهود
ولأن الألف واللام يدخلان للتعريف وليس هاهنا معرفة يحمل اللفظ
عليه غير الجنس فوجب أن يحمل عليه
واحتجوا بأن الألف واللام لا يدخلان إلا للعهد ولهذا قال الله عز و جل كما
أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول وأراد به العهد وقال عز و جل
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وأراد به العهد ولهذا قال ابن عباس
رضي الله عنه ولن يغلب عسر واحد يسرين أبدا وتقول دخلت السوق فرأيت رجلا
ثم عدت إلى السوق فرأيت الرجل وتريد به العهد فدل على أن مقتضاه العهد
قلنا إنما حملناه فيما ذكروه على العهد لأنه قد تقدمه نكرة فرجع التعريف
إليها وليس كذلك هاهنا فإنه لم تتقدمه نكرة فحمل على تعريف الجنس لأن
الألف واللام يدخلان للتعريف وليس هاهنا معرفة يحمل اللفظ عليها غير الجنس
فوجب أن يحمل عليه
قالوا ولأن الألف واللام لا تفيد أكثر من تعريف النكرة فإذا كانت النكرة
من الاسم المفرد لا تقتضي إلا واحدا من الجنس فإذا دخلت عليه الألف واللام
وجب أن لا تقتضي إلا واحدا من الجنس
قلنا هذا يبطل به إذا دخلت على اسم الجمع فإنها لا تفيد أكثر من تعريف
النكرة ثم إذا دخلت على اسم الجمع اقتضت الجنس وعلى أنه إنما يقتضي تعريف
النكرة إذا تقدمه نكرة فأما إذا لم يتقدمه نكرة اقتضى تعريف الجنس وهاهنا
لم يتقدمه نكرة فوجب أن يكون تعريفا للجنس
مسألة 3
أسماء الجموع إذا تجردت عن الألف واللام لم تقض العمومومن أصحابنا من قال تقتضي العموم وهو قول الجبائي
لنا أنه نكرة في الإثبات فلم يقتض العموم كالاسم المفرد
ولأنه لو كان مقتضيا للجنس كله لما كان يسمى نكرة لأن الجنس كله معروف ولهذا لا يسمى نكرة إذا دخله الألف واللام
وأيضا هو أنه يصح تأكيد ب ما فتقول أعط رجالا ما فلو كان موضوعا للجنس لما صح فيه التأكيد ب ما كما لا يجوز في العرف بالألف واللام
واحتجوا بأنه يصح استثناء كل واحد من الجنسين من هذا اللفظ فدل على أنه يقتضي الجنس
والجواب هو أنا لا نسلم فإن الاستثناء لا يصح من أسماء الجموع إذا تجردت عن الألف واللام فإذا قال كلم رجالا إلا زيدا فهو مجاز
مسألة 4
إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم لم يجز اعتقاد عمومه حتى ينظر في الأصول فإن لم يجد ما يخصه اعتقد عمومه في قول أبي العباس وقال أبو بكر الصيرفي يعتقد في الحال عمومه
لنا هو أن الذي يقتضي اعتقاد العموم تجرد هذه الصيغة عما يخصها لأنها إذا
وردت ولم تتجرد عن دليل التخصيص لم تقتض العموم ولا نعلم تجردها عما يخصها
إلا بالنظر والبحث فلم يجز اعتقاد عمومها قبل النظر والبحث يدل عليه أن
الشهادة لما كانت بينة عند التجرد عن الفسق لم يحكم بكونها بينة قبل البحث
عن حالها فكذلك هاهنا
احتجوا بأن اللفظ موضوع للجنس والطبقة فوجب اعتقاد موجبه قبل النظر كأسماء
الحقائق لما كانت موضوعة لما وضعت له من الأعيان وجب اعتقاد موجبها في
الحال كذلك هاهنا
قلنا اللفظ موضوع للجنس إذا تجرد عما يخصه وهذا غير معلوم قبل البحث فلا
يصح هذا الإطلاق وأما أسماء الحقائق فيحتمل أن يقال إنها لا تحمل على
مسمياتها قبل البحث وإن سلمنا فالفرق بينهما هو أن الحقائق إذا استعملت في
غيرها صارت مجازا فلم يجز ترك الحقيقة إلى المجاز من غير دليل وليس كذلك
لفظ العموم فإنه إذا حمل على الخصوص لم يصر مجازا فوجب التوقف فيه
قالوا ولأن هذا القول يؤدي إلى التوقف أبدا لأنه إذا نظر فخفى
عليه دليل التخصيص جوز أن يلحق في النظر الثاني ما خفى عليه في الأول
ويلحق في النظر الثالث ما خفى عليه في الثاني فيجب التوقف فيه أبدا وهذا
لا يجوز
قلنا هذا يبطل بطلب النص في الحادثة فإنه يجب وإن جوزنا أن يلحق بالنظر
الثاني ما خفى عليه في الأول ويلحق بالثالث ما خفي عليه في الثاني ويبطل
أيضا بالسؤال عن حال الشهود فإنه يجب عليه وإن كان يجوز أن يظهر له في
السؤال الثاني ما خفي عليه في الأول وفي السؤال الثالث ما خفي عليه في
الثاني
قالوا ولأنه في حال سماع اللفظ لا يخلو من اعتقاده ولا يمكنه أن يعتقد
الخصوص فوجب أن يعتقد العموم
قلنا يعتقد أنه عام إذا تجرد عما يخصه ولا يقطع فيه بالعموم ولا بالخصوص
قالوا ولأن اللفظ مخصوص في الأعيان والأزمان ثم يجب حمله على العموم في
جميع الأزمان وإن جاز أن يكون منسوخا في بعض الأزمان فكذلك يجب حمله على
العموم في الأعيان وإن جاز أن يكون مخصوصا في بعض الأعيان
قلنا النسخ إنما يرد بعد اللفظ فلا يجب التوقف لأجله كما إذا عرف عدالة
الشهود لم يجب التوقف لما يرد عليهم من الفسق وليس كذلك في التخصيص فإنه
قد يكون مقارنا للعموم وقد يكون متقدما عليه فوجب التوقف لأجله كما يجب في
حال الشهود قبل الكشف عن حالهم
قالوا ولأن هذا يؤدي إلى الوقف في العموم وقد أنكرتم ذلك على أهل التوقف
قلنا هذا مخالف لوقف أهل الوقف وذلك أنا إذا لم نجد في الأصول ما يوجب
التخصيص حملناه على العموم وأهل الوقف إذا لم يجدوا ما يوجب التخصيص وقفوا
أبدا حتى يجدوا دليلا على المراد فبان الفرق بين القولين
مسألة 5
العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما بقيوقالت المعتزلة يصير مجازا سواء خص بلفظ متصل أو بلفظ منفصل وهو قول عيسى بن أبان
وقال أبو الحسن الكرخي إن خص بلفظ متصل لم يصر مجازا
وإن خص بلفظ منفصل صار مجازا
لنا هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة وقد وجد الاستثناء والشرط والغاية
في الاستعمال أكثر من أن يعد ويحصى فدل على أن ذلك حقيقة
ولأن فوائد اللفظ تختلف بما يدخل عليها من الزيادة والنقصان ألا ترى أنك
تقول زيد في الدار فيكون خبرا ثم تزيد فيه ألف الاستفهام فتقول أزيد في
الدار فيصير استخبارا فلو قلنا إن ما اتصل باللفظ من الشروط والاستثناء
يجعل الكلام مجازا فيما بقي لوجب أن يكون قوله أزيد في الدار حجازا في
الاستفهام لأنه لو سقط منه ألف الاستفهام لكان حقيقة في الخبر وفي ركوب
هذا إبطال لفوائد الألفاظ
ولأن الكلام إنما يكون مجازا إذا عرف أنه حقيقة في شيء ثم استعمل في غيره
كالحمار حقيقة في البهيمة المعروفة ثم يستعمل في الرجل البليد فيكون مجازا
والعموم مع الاستثناء ما استعمل في غير هذا الوضع على سبيل الحقيقة فلا
يجوز أن يجعل مجازا في هذا الوضع
والدليل على من فرق بين اللفظ المتصل والمنفصل هو أن للمتصل
لفظا يقتضي تخصيص العموم فلم يصيره مجازا في الباقي دليله الشرط
والاستثناء
ويدل عليه هو أن اللفظ اقتضى استغراق الجنس أجمع فإذا دل الدليل على أن
بعض الجنس غير مراد بقي الباقي على مقتضى اللفظ فوجب أن يكون حقيقة فيه
واحتجوا بأن اللفظ موضوع لاستغراق الجنس فإذا خص صار مستعملا في غير ما
وضع له فصار مجازا كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع والحمار في الرجل
البليد
قلنا هذا يبطل به إذا قيده بالشرط والغاية أو خصه بالاستثناء على قول من
سلم ذلك فإنه موضوع للجنس وقد استعمل الاستثناء في غير ما وضع له ثم لم
يصر مجازا
فإن قيل هو مع الاستثناء موضوع للخصوص لا للعموم فما استعمل إلا فيما وضع
له
قيل وكذلك عندنا لفظ العموم مع دلالة التخصيص موضوع للخصوص فما استعمل إلا
فيما وضع له
ويخالف هذا ما ذكروه من استعمال الأسد في الرجل الشجاع والحمار في الرجل
البليد فإن الأسد لم يوضع للرجل الشجاع ولا الحمار للرجل البليد في اللغة
فإذا استعمل في ذلك علمنا أنه مجاز وليس كذلك لفظ العموم فإنه متناول لكل
واحد من الجنس فإذا استعمل في الخصوص فقد استعمل فيما يقتضيه اللفظ يدل
عليه أن القرينة فيما ذكروه تبين ما أريد باللفظ والقرينة فيما اختلفنا
فيه تبين ما لا يراد باللفظ فبقي الباقي على مقتضى اللفظ
مسألة 6
يجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى واحد من قول أكثر أصحابناوقال أبو بكر القفال يجوز تخصيصها إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر من ذلك
لنا أنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه إلى أن يبقى أقل من
ثلاثة
دليله من وما ولأن ما جاز تخصيص العموم به إلى الثلاثة جاز التخصيص به إلى
الواحد دليله الاستثناء
واحتجوا بأن اسم الجمع لا يستعمل فيما دون الثلاثة فالحمل عليه إسقاط له
فلم يصح إلا بما يصح به الشرط
قلنا لا نسلم فإنه يجوز أن يستعمل لفظ الجمع فيما دون الثلاثة ولهذا قال
الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وأراد به نعيما
وقال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون وأراد به عائشة رضي الله عنها وحدها
وعلى أن هذا يفسد به إذا خصه بالاستثناء فإنه يجوز وإن كان اللفظ لا
يستعمل إلا فيما دونه
مسألة 7
أقل الجمع ثلاثةومن أصحابنا من قال اثنان وهو مذهب ابن داود
ونفطويه والقاضي أبي بكر الأشعري
لنا ما روى أن ابن عباس احتج على عثمان رضي الله عنهما في أن الأخوين لا
يحجبان الأم من الثلث إلى السدس بقوله تعالى وإن كان له إخوة فلأمه السدس
قال وليس الأخوان إخوة في لسان قومك فقال له عثمان رضي الله عنه لا أستطيع
أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار
فلو لم يكن ذلك مقتضى اللفظ لما صح احتجاجه ولما أقره عليه عثمان وهما من
فصحاء العرب وأرباب اللسان
فإن قيل فقد روي عن زيد بن ثابت أنه قال الأخوان أخوة فصار مخالفا له
قلنا المراد بتلك أنهما كالأخوة في الحجب والذي يدل عليه أن
أحدا لا يقول إن لفظ التثنية يتناول الجمع حقيقة وإنما اختلفوا في لفظ
الجمع هل يتناول الاثنين حقيقة
وأيضا هو أن أهل اللغة فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع فقالوا رجل
ورجلان ورجال ولو كان الاثنان جمعا لكان لفظ التثنية مساويا لما زاد عليه
كما كان لفظ الثلاثة مساويا لما زاد عليه
فإن قيل لا يمتنع أن يكون للتثنية أسماء تخصها ويكون اسم الجمع أيضا
متناولا لها كالأسد له اسم يخصه ومع ذلك اسم السبع حقيقة فيه
قيل السبع والأسد لم يوضع للتمييز بين شيئين وإنما جعل أحدهما اسما للجنس
والآخر اسما للنوع وليس كذلك لفظ التثنية والجمع فإنهما وضعا لنوعين
مختلفين من العدد على وجه التمييز بينهما فدل على أن كل واحد منهما يختص
بما يميز به كالأسد والحمار لما وضع لجنسين من الحيوان كان كل واحد منهما
اسما لما وضع له خاصة
ولأنه لو كان اسم الجمع حقيقة في الاثنين لكان لا يصح نفيه لأن الحقائق لا
يصح نفيها عن مسمياتها ولما جاز أن يقول ما رأيت رجالا وإنما رأيت رجلين
دل على أن حقيقته ما ذكرناه
ولأنه لا خلاف بين أصحابنا أنه إذا قال لفلان علي دراهم لزمه ثلاثة ولو
كان أقل الجمع اثنين لما لزمه أكثر من اثنين
واحتجوا بقوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم
القوم وكنا لحكمهم شاهدين فرد الكناية إلى الاثنين بلفظ الجمع وبقوله
تعالى إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان
بغى بعضنا على بعض فاستعمل في الاثنين لفظ الجمع
قلنا أما الآية الأولى فقد قيل إن المراد بها حكم الأنبياء
عليهم السلام وهو جماعة كثيرة وقيل المراد بها داود وسليمان والمحكوم له
لأن ذكر الحاكم يقتضي ذكر المحكوم له فلهذا رد الكناية إليهم بلفظ الجمع
وأما الآية الثانية فلا حجة فيها لأن الخصم يقع على الواحد والجماعة ولهذا
قال الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فجعل أحدهم المؤمنين والآخر
الكفار
ولأنه يجوز أن يكون مع جبريل عليه السلام وميكال عليه السلام جماعة من
الملائكة عليهم السلام
واحتجوا بقول النبي عليه السلام الاثنان فما فوقهم جماعة
والجواب أن هذا دليل لنا فإنه لو كان الاثنان جمعا حقيقة لما احتاج إلى
البيان لأنهم يعرفون من اللغة ما يعرفه وإن كان النبي صلى الله عليه و سلم
أفصح العرب ولما بين دل على أن الاثنين ليس بجمع في اللغة فيجب أن يحمل
الخبر على أنه قصد بيان حكم شرعي وأن الاثنين في حكم الجماعة في الصلاة
قالوا ولأن الجمع إنما سمي جمعا لما فيه من جمع الآحاد وذلك يوجد في
الاثنين فوجب أن يكون جمعا
قلنا ويجوز أن يكون اشتقاقه من ذلك ثم لا يسمى به كل ما وجد فيه هذا
المعنى بل يختص بشيء مخصوص كالقارورة سميت بذلك لأنها يستقر فيها الشيء ثم
يختص ذلك بظرف مخصوص وإن كان هذا المعنى يوجد في غيره وكذلك سميت الدابة
لأنها تدب على وجه الأرض ثم يختص ذلك ببهيمة مخصوصة وإن كان المعنى يوجد
في غيرها فكذلك هاهنا
قالوا ولأن الاثنين يخبران عن أنفسهما فيقولان فعلنا كما يخبر
الثلاثة فيقولون فعلنا فدل على أن الجمع فيهما واحد
قلنا هذا يعارضه أنهم فرقوا بينهما في فعل الغائب والمواجهة فقالوا في
الغائب ضربا في الاثنين وضربوا في الثلاثة وفي المواجهة ضربتما في الاثنين
وضربتم للجماعة وليس لهم أن يتعلقوا بما ذكروه إلا ولنا أن نتعلق بما
ذكرناه
ولأنه لا يمتنع أن يكون لفظهما في الإخبار عن أنفسهما واحدا يكون لفظهما
في الجمع يختلف ألا ترى أن المذكر والمؤنث في الإخبار عن أنفسهما سواء ثم
لفظهما في الجمع يختلف فكذلك ههنا
مسألة 8
يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحدوقال بعض المتكلمين لا يجوز
وقال عيسى ابن أبان ما خص بدليل جاز تخصيصه بأخبار
الآحاد وإن لم يخص لم يجز تخصيصه بأخبار الآحاد
لنا هو أن المسلمين أجمعوا على تخصيص آية المواريث بقوله عليه السلام لا
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وعلى تخصيص قوله فانكحوا ما طاب لكم
من النساء بقوله صلى الله عليه و سلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على
خالتها
واحتج أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها بقوله صلى
الله عليه و سلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وهذا تخصيص
لعموم من القرآن بجبر الواحد فدل على جواز ذلك
فإن قيل فقد رد عمر رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس أن
النبي صلى الله عليه و سلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى لما خالف
قوله الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقال لا ندع قول كتاب الله
بقول امرأة
قيل إنما رد خبرها لأنها اتهمها ولهذا قال امرأة لا ندري صدقت أم كذبت
وكلامنا فيما صح من الأخبار وسكنت نفس المجتهد إليه
ولأنهما دليلان أحدهما أخص من الآخر فقدم الخاص منهما على العام كما لو
كانا من الكتاب والسنة
ولأن في هذا جمعا بين دليلين فكان أولى من إسقاط أحدهما كما لو كانا من
الكتاب أو السنة
ولأن خصوص القرآن أو السنة إنما قدم على عمومهما لأنه يتناول الحكم بخصوصه
على وجه لا يحتمل غير ما تناوله وعمومهما يتناول الحكم بعمومه على وجه
يحتمل أن يكون المراد به غير ما تناوله الخصوص وهذا المعنى موجود في خصوص
السنة وعموم القرآن فوجب أن يقدم عليه
واحتجوا بأن الكتاب مقطوع به وخبر الواحد غير مقطوع به فلا يجوز ترك
المقطوع به بغيره كالإجماع لا يترك بخبر الواحد
قلنا خبر الواحد وإن كان من طريق الظن إلا أن وجوب العمل به
معلوم بدليل مقطوع به فكان حكمه وحكم ما قطع بصحته واحد
ولأن الكتاب إنما يقطع بورود لفظه عاما فأما مقتضاه من العموم فغير مقطوع
به لأنه يحتمل أن يراد به غير ما تناوله خصوص السنة والخاص لا يحتمل غير
ما تناوله فوجب أن يقدم عليه يبين صحة هذا هو أنه لو قطع بعمومه لقطع على
كذب الخبر وهذا لا يقوله أحد ويخالف ما ذكروه من الإجماع إذا عارضه خبر
الواحد فإن الإجماع لا إجمال فيما تناوله وخبر الواحد يحتمل أن يكون
منسوخا فقدمنا الإجماع عليه وهاهنا عموم القرآن محتمل لما يقتضيه وخصوص
السنة غير محتمل فقدم خصوص السنة
قالوا ولأنه إسقاط بعض ما يقتضيه عموم القرآن بالسنة فلم يجز كالنسخ
قلنا النسخ إسقاط لموجب اللفظ فلم يجز إلا بمثله أو بما هو أقوى منه
والتخصيص بيان ما أريد باللفظ فجاز بما دونه
واحتج عيسى بن أبان بأنه إذا دخله التخصيص صار مجازا فقيل خبر الواحد في
تخصيصه كما قبل في بيان المجمل وإذا لم يدخله التخصيص بقي على حقيقته فلم
يخص خبر الواحد
والجواب هو أن المجمل مالا يعقل المراد منه بنفسه والعموم وإن خص فمعناه
معقول وامتثاله ممكن واللفظ متناول لما يبقى بعد التخصيص فكان حكمه وحكم
مالم يخص واحد
مسألة 9
يجوز تخصيص عموم السنة بالكتابومن الناس من قال لا يجوز
لنا قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولم يفصل
ولأنه لفظ خاص عارض لفظا عاما فخصه دليله إذا كانا من الكتاب أو كانا من السنة
ولأن الكتاب مقطوع بطريقه والسنة غير مقطوع بها فإذا جاز تخصيص الكتاب بالسنة فتخصيص السنة بالكتاب أولى
واحتجوا بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم فجعل السنة بيانا للقرآن
قلنا هذا محمول على ما يفتقر إلى البيان أو نحمله على أن المراد به الإظهار يدلك عليه أنه علقه على جميع القرآن فالذي يفتقر إليه جميع القرآن هو الإظهار فأما التخصيص فلا يحتاج إليه جميعه
مسألة 10
يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي ومن أصحابنا من قال لا يجوز ذلك وهو قول أبي علي الجبائي
وقال أصحاب أبي حنيفة إن خص بغيره جاز التخصيص به
وإن لم يخص بغيره لم يجز
لنا هو أنه دليل ينافي بعض ما شمله العموم بصريحه فوجب أن يخص به كاللفظ
الخاص ويدل عليه هو أن العلة معنى النطق فإذا كان النطق الخاص يخص به
العموم فكذلك معناه
ولأن ما ذكرناه جمعا بين دليلين فكان أولى من إسقاط أحدهما كاللفظ الخاص
مع النطق العام
ولأن القياس الخفي دليل فكان حكمه حكم الجلي من جنسه في تخصيص العموم كخبر
الواحد لما كان دليلا كان حكمه حكم الجلي من جنسه وهو المتواتر
والدليل على أصحاب أبي حنيفة هو أن ما جاز أن يراد به في التخصيص جاز أن
يبتدأ به التخصيص كالنطق
ولأن التخصيص إنما جاز بالقياس لأنه يتناول الحكم بخصوصه فقدم على العام
وهذا موجود في الابتداء فوجب أن يقدم عليه
واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لمعاذ رضي الله عنه
فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أجتهد رأيي ولو آلو
فدل على أن القياس لا يعمل به مع السنة
قلنا القدر الذي يخرجه القياس من العموم ليس من السنة عندنا ولأنه
كما رتب القياس على السنة فقد رتب السنة على الكتاب ثم لا خلاف
أن تخصيص الكتاب بالسنة جائز فكذلك تخصيص السنة بالقياس
قالوا ولأنه إسقاط لما تناوله العموم فلا يجوز بالقياس كالنسخ وربما قالوا
تخصيص الأعيان أحد نوعي تخصيص العموم فلا يجوز بالقياس كتخصيص الزمان
قلنا لا يمتنع أن لا يجوز به النسخ ويجوز به التخصيص ألا ترى أن نسخ
القرآن لا يجوز بخبر الواحد وتخصيصه جائز ولأن النسخ إسقاط موجب اللفظ
والتخصيص جمع بينه وبين غيره فافترقا
قالوا ولأنه تخصيص عموم بالقياس فلم يجز كما لو كان القياس بعلة مستنبطة
من العموم
قلنا هذا يبطل بالتخصيص بالقياس الجلي ثم لا يمتنع أن لا يجوز بما انتزع
منه ويجوز بما انتزع من غيره كما لا يجوز التخصيص بنفسه ويجوز التخصيص
بغيره من الألفاظ
ولأنه المطلوب هناك علة الحكم الذي اقتضاه العموم فإن اقتضت العلة التخصيص
لم يكن ذلك علة الحكم لأنه مسقط له وليس كذلك هاهنا لأن المطلوب علة حكم
مخالف له فجاز أن يخص به
قالوا ولأن القياس فرع النطق فلا يجوز أن يسقط الفرع أصله
قلنا نحن إنما نخص به عموما ليس بأصله فلا يكون ذلك إسقاط أصل بفرع
قالوا ولأن ما قدم عليه القياس الجلي في الحكم لا يخص به العموم كاستصحاب
الحال
قلنا استصحاب الحال ليس بدليل وإنما هو بقاء على حكم الأصل إلى
أن يرد الدليل عليه فلا يترك له ما هو دليل وليس كذلك القياس فإنه دليل من
جهة الشرع يستدعي الحكم بصريحه فقدم على ما يقتضي الحكم بعمومه كخبر
الواحد
قالوا ولأن قياس الشبه مختلف فيه بين القائلين بالقياس فلا يخص به العموم
كالخبر المرسل لما كان مختلفا فيه بين القائلين بخبر الواحد لم يخص به
العموم
قلنا نحن إنما نتكلم مع من قال بقياس الشبه ومن قال به وجعله دليلا لزمه
التخصيص به وإن كان في الناس من لا يقول به ألا ترى أن القياس الجلي لما
كان حجة عند القائلين بالقياس وجب تخصيص العموم به وإن كان مختلفا فيه
ويخالف الخبر المرسل فإن ذلك ليس بحجة عندنا فلا يجوز تخصيص العموم به
وقياس الشبه حجة على المذهبين فجاز تخصيص العموم به كالقياس الجلي
قالوا ولأن القياس يقتضي الظن وعموم الكتاب يوجب العلم فلا يجوز أن يعترض
به عليه
قلنا يبطل بالقياس إذا ورد على براءة الذمة بالعقل فإنه يوجب الظن ثم
يعترض به عليه وإن كان ما يوجبه العقل من براءة الذمة مقطوع به
فإن قيل العقل يقتضي براءة الذمة بشرط وهو أن لا يرد سمع والعموم يقتضي
الحكم على إطلاقه
قيل وكذا اللفظ العام يقتضي العموم ما لم يرد ما هو أقوى منه والقياس
الخاص أقوى منه في تناول الحكم فقضى به عليه
ولأن القياس وإن كان طريقه الظن والاجتهاد إلا أن الدليل على وجوب العمل
به مقطوع بصحته فقد صار كالعموم في هذا الباب وزاد عليه بأنه
يكشف عن المراد بالعموم ويتناول الحكم بخصوصه فكان أولى منه
واحتج أصحاب أبي حنيفة بأنه إسقاط دلالة اللفظ فلم يجز بالقياس كالنسخ ولا
تلزم الزيادة بالتخصيص لأنها ليست بإسقاط لدلالة اللفظ لأن الدلالة قد
سقطت بغيره
قلنا لا يمتنع أن لا يجوز النسخ ويجوز التخصيص ألا ترى أن نسخ الكتاب لا
يجوز بخبر الواحد ويجوز التخصيص به ولأن النسخ إسقاط اللفظ وهذا جمع بينه
وبين غيره فافترقا
مسألة 11
يجوز تخصيص الخبر كما يجوز تخصيص الأمر والنهيومن أصحابنا من قال تخصيص الخبر لا يجوز
لنا هو أنه يجوز أن يكون المراد بعض ما تناوله العموم كما يجوز ذلك في الأمر والنهي فإذا جاز التخصيص هناك جاز ههنا
واحتجوا بأنه أحد نوعي التخصيص فلم يجز في الخبر كالنسخ
قلنا النسخ يسقط جميع مقتضى اللفظ فلو دخل في الخبر صار كذبا والتخصيص لا يسقط جميع ما اقتضاه وإنما يبين ما يراد به فافترقا
مسألة 12
إذا ورد العام على سبب خاص واللفظ مستقل بنفسه حمل على عمومه ولم يقتصر على سببه
وقال مالك يقتصر على السبب وهو قول المزني وأبي ثور وأبي بكر القفال
والدقاق
لنا هو أن الدليل قول صاحب الشريعة فاعتبر عمومه كما لو تجرد عن السبب
ولأن كل لفظ لو تجرد عن سؤال خاص حمل على عمومه فكذلك إذا تقدمه
سؤال خاص
الدليل عليه إذا قالت المرأة لزوجها طلقني فقال كل امرأة لي طالق ويدل
عليه هو أن الحكم يتعلق بجواب النبي عليه السلام كما أن الطلاق يتعلق بقول
الزوج ثم الاعتبار بعموم كلام الزوج دون خصوص السؤال فكذلك يجب أن يكون
الاعتبار بعموم كلام النبي صلى الله عليه و سلم لا بخصوص السؤال
ولأنه لو كان السؤال عاما والجواب خاصا اعتبر خصوص الجواب دون عموم السؤال
فكذلك إذا كان السؤال خاصا والجواب عاما وجب أن يعتبر عموم الجواب
ولأنه لو وقع السؤال عن جواز شيء فخرج الجواب بإيجابه اعتبر الجواب فكذلك
إذا كان السؤال خاصا والجواب عاما وجب أن يعتبر عموم الجواب
ولأن قول السائل ليس بحجة فلا يجوز أن يخص به عموم السنة كقول غيره
ولأنه لو كان الاعتبار بخصوص السؤال لوجب أن يختص السائل بالجواب حتى لا
يدخل غيره فيه وقد أجمع المسلمون على عموم آية القذف وإن كانت نزلت في شأن
عائشة رضي الله عنها خاصة وعموم آية اللعان وإن كانت نزلت في شان هلال بن
أمية وامرأته وعموم آية الظهار وإن كانت نزلت في شأن رجل بعينه فدل على
أنه لا اعتبار بالسبب
واحتجوا بأن السؤال مع الجواب كالجملة الواحدة بدليل أن السؤال هو المقتضي
للجواب وبدليل أن الجواب إذا كان مبهما أحيل في بيانه على السؤال فإذا ثبت
أنهما كالجملة الواحدة وجب أن يصير السؤال مقدرا في الجواب فيخص الحكم
قلنا لا نسلم أنهما كالجملة الواحدة بل هما جملتان متفرقتان
واستدلالهم عليه بأن الجواب مقتضى السؤال لا يسلم فكيف يكون الجواب مقتضى
السؤال وهو أعم منه
وإن سلمنا لهم فالجواب عنه وإن كان مقتضاه فإنه يجوز أن يكون زائدا عليه
فيجيب بما هو أعم منه وربما اشتمل الجواب عما لم يقع السؤال عنه كما قال
الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على
غنمي ولي فيها مآرب أخرى فأجاب عما سئل وزاد كما قال عليه السلام وقد سئل
عن ماء فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته
وقولهم إنه يجوز أن يكون الجواب محالا على السبب في البيان يبطل بالكتاب
مع السنة فإنه يجوز أن يحال بأحدهما على الآخر في البيان ثم هما جملتان
مختلفتان وعلى أن خلافنا في جواب مستقل بنفسه غير مفتقر إلى السؤال في
البيان فلا يجوز أن يجعل ذلك مع السؤال جملة واحدة ثم هذا يبطل بما ذكرناه
من مسألة الطلاق فإن السؤال هو المقتضي للطلاق ويجوز أن يكون الجواب محالا
على السؤال في البيان ثم لا يجعل السؤال مع الجواب كالجملة الواحدة
قالوا ولأنه جواب خرج على سؤال خاص فكان مقصورا عليه كما لو لم يستقل إلا
بالسبب
قلنا المعنى هناك أن اللفظ لم يتناول غير ما وقع عنه السؤال وليس كذلك
هاهنا فإن اللفظ عام مما وقع عنه السؤال وغيره فحمل على عمومه
قالوا ولما ورد الخطاب فيه على السبب دل على انه بيان لحكمه خاصا إذ لو
كان بيانا لغيره لبينه قبل السؤال
قلنا يجوز أن يرد السؤال عليه ويبين حكمه وحكم غيره كما سئل عن
ماء البحر خاصة فبين حكمه وحكم ميتته ثم هذا يعارضه أنه لو كان بيانا لحكم
السبب خاصة لخصه بالجواب ولما أطلق وعم دل على أنه قصد بيانه وبيان غيره
قالوا السبب هو الذي أثار الحكم فيعلق به كالعلة
قلنا العلة مقتضية للحكم فوزانها من السبب أن يكون مقتضيا للحكم فيتعلق به
الحكم وليس كذلك هاهنا لأن السبب غير مقتض له لأنه لا يجوز أن يكون مقتضيا
له وهو أعم منه فلم يجز تعليقه عليه
مسألة 13
تخصيص العموم بقول الراوي ومذهبه لا يجوز ولا يجوز أيضا ترك شيء من الظواهر بقولهوقال بعض أصحاب أبي حنيفة يجوز
لنا هو أن الراوي محجوج بالخبر فلا يجوز التخصيص بقوله كغيره
ولأن تخصيصه الخبر يجوز أن يكون بخبر آخر ويحتمل أن يكون بضرب من الرأي اعتقد صحته وهو فاسد فلا يجوز ترك الظاهر بالشك
ولأن هذا يؤدي إلى أن يصير قول الراوي حجة ويخرج قول النبي صلى الله عليه و سلم أن يكون حجة وذلك محال
واحتجوا بأن الظاهر أن الراوي لا يترك ما رواه إلا وقد عرف من جهة الرسول عليه السلام ما يوجب التخصيص
قلنا الظاهر أنه لم يخصصه من جهة النقل والرواية لأنه لو كان معه نقل
لذكره في وقت من الأوقات وعلى أنه يحتمل ما ذكروه ويحتمل أن
يكون قد ذهب إلى رأي باطل واستدلال فاسد فلا يجوز ترك الظاهر
قالوا ولأنه لا يخلو إما أن يكون خصه بخبر أو قياس وبأيهما كان وجب المصير
إليه
قلنا إنما يجب ذلك إذا عرفنا المخصص فأما إذا لم نعلمه لم يجز لأنه يجوز
أن يكون قد خصه بقياس فاسد وطريق باطل فلا يجوز ترك الخبر
قالوا إذا قبلتم قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أو نهانا وغير
ذلك من الألفاظ وجب أن تقبلوا قوله فيما يوجب التخصيص
قلنا هذه الألفاظ رواية عن النبي صلى الله عليه و سلم ونقل عنه فوزانه من
مسألتنا أن ينقل إلينا عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يوجب تخصيصه
فافترقنا
مسألة 14
إذا تعارض لفظان خاص وعام بنى العام على الخاصوقال بعض المتكلمين لا يقضى على العام بالخاص بل يتعارض الخاص وما قابله من العام وهو اختيار أبي بكر الأشعري وأبي بكر الدقاق
لنا هو أنه دليل عام قابله دليل خاص وليس في تخصيصه إبطال له فوجب تخصيصه به كخبر الواحد إذا ورد مخالفا لدليل العقل فإنه يخص بدليل العقل
ولأن الخاص أقوى من العام لأن الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا احتمال فيه والعام يتناول الحكم على وجه محتمل لأنه يجوز أن يكون المراد به غير ما تناوله الخاص بخصوصه فوجب أن يقدم الخاص عليه
ولأن الأدلة إنما وردت للاستعمال فكان الجمع بينهما أولى من إسقاط بعضها والتوقف فيها
ولأن ما تفرق من ألفاظ صاحب الشرع بمنزلة المجموع موضعا واحدا
ولو جمع النبي عليه السلام بين اللفظين لجمع بينهما ورتب أحدهما على الآخر
فكذلك إذا تفرق
واحتجوا بأنه ليس الخاص فيما تناوله بأولى مما عارضه من العام فوجب التوقف
فيه
قلنا قد بينا بأن الخاص فيما تناوله أولى من العام لأن الخاص يقتضي الحكم
بصريحه على وجه لا احتمال فيه والعام يتناوله بظاهره وعمومه على وجه يحتمل
أن يكون المراد به غير ظاهره فوجب تقديم الأقوى منهما كما قدمنا دليل
العقل على عموم خبر الواحد
ولأن فيما قلناه استعمال دليلين وفيما قلتم إسقاط أحدهما فكان ما قلناه
أولى
مسألة 15
إذا تعارض عام وخاص بني العام على الخاص وإن كان الخاص متقدما على العاموقال بعض المعتزلة وبعض أصحاب أبي حنيفة متى تقدم الخاص نسخه العام ولم يبن أحدهما على الآخر وإن تقدم تاريخهما بني العام على الخاص في قول بعضهم
وقال عيسى بن أبان والكرخي والبصري إذا عدم تاريخهما رجع بالأخذ بأحدهما إلى دليل كالعمومين إذا تعارضا بأحدهما
لنا بأنه تعارض دليلان عام وخاص فبني العام على الخاص كما لو لم يتقدم الخاص ولأنه يمكن الجمع بين الدليلين فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر كما لو لم يتقدم الخاص
ولأنه إذا لم يتقدم الخاص قضي به على العام لأنه يتناول الحكم بصريحه من غير احتمال والعموم يتناوله مع الاحتمال وهذا المعنى موجود فيه وإن تقدم الخاص فوجب أن يقضي به
ولأن ما أوجب تخصيص العموم لا فرق بين أن يتأخر أو يتقدم
كالقياس لا فرق بين أن يكون مستنبطا من أصل متقدم أو أصل متأخر فكذلك
هاهنا
ولأن الخبر الخاص أقوى من القياس فإذا جاز تخصيص العموم بقياس مستنبط من
أصل متقدم وروده على العموم فلأن يجوز بالخبر الخاص أولى
ولأنه لا خلاف أن تخصيص العموم بأدلة العقل جائز وإن كانت متقدمة عليه
فكذلك هاهنا
فإن قيل أدلة العقل لا يمكن نسخها فقضي بها على العموم والخاص يصح نسخه
فنسخ به
والجواب أنه إن كان لا ينسخ دليل العقل فلا ينسخ الخاص أيضا إلا بمثله
والعام ليس مثل الخاص في القوة فلا يجب أن ينسخ به
ولأن الخاص المتقدم متيقن ونسخه بما ورد من اللفظ العام غير متيقن فلا
يجوز نسخ المتيقن بغير متيقن
ولأنه لا فرق في اللغة بين قوله لا تعط فلانا حقه وأعط الناس حقوقهم وبين
قوله أعط الناس حقوقهم ولا تعط فلانا حقه
فإنه يعقل من الكلامين تخصيص العام منهما وبنى أحد اللفظين على الآخر فوجب
أن يكونا فيما اختلفا فيه مثله
واحتجوا فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنا نأخذ من أوامر
رسول الله صلى الله عليه و سلم بالأحدث فالأحدث
والجواب هو أنا نأخذ بالأحدث فالأحدث على حسب ما يقتضيه والذي يقتضيه هو
القدر الذي يبقى معه التخصيص على أنه يعارضه قوله عز و جل ويقولون نؤمن
ببعض ونكفر ببعض فذم من عمل بالبعض دون البعض وهم
يأخذون بالمتأخير ويتركون المتقدم ثم يحمل ما رواه على لفظين لا
يمكن استعمالهما فيؤخذ بالأحدث منهما
قالوا ولأنهما لفظان متعارضان فنسخ الأول منهما بالثاني كالنصين
قلنا المعنى في النصين أنه لا يمكن الجمع بينهما فنسخ الأول منهما بالثاني
وفي مسألتنا يمكن الجمع بينهما فلا يجوز إسقاط أحدهما بالآخر
قالوا ولأن العام إذا تناول الجنس لعمومه كان كعدة ألفاظ يتناول كل واحد
منهما واحدا من الجنس ثم ثبت أن ما ورد اللفظ به خاصا في كل واحد منهما
إذا تقدم ثم ورد ما يخالفه بألفاظ خاصة نسخه كذلك إذا ورد اللفظ الخاص ثم
ورد عام يخالفه وجب أن ينسخه
قلنا لو كان جمع الجنس بلفظ واحد كإفراد كل واحد منه بلفظ يخصه كان جمعه
بلفظ كإفراد كل واحد منهما بلفظ في المنع من التخصيص بالقياس ولما بطل هذا
بإجماع بطل ما قالوه
ولأنه لو كان جمع الجنس بلفظ عام كإفراد كل واحد منه بلفظ خاص لكان لا
يجوز ورود لفظ عام مخالفا لدليل العقل كما لا يجوز أن يرد لفظ خاص يخالف
دليل العقل
ولأنه إذا وردت به ألفاظ مفردة لم يكن الجمع بينها وبين ما يعارضها فوجب
نسخ المتقدم بالمتأخر وليس كذلك هاهنا فإنه إذا ورد اللفظ عاما أمكن الجمع
بينه وبين ما يعارضه فبني أحدهما على الآخر
قالوا ولأنه الخاص إذا تقدم على العام كان ذلك بيانا للعام بعده على قولكم
والبيان لا يجوز أن يتقدم على المبين كما لا يجوز أن يتقدم التفسير على
المفسر والاستثناء على الجملة
قلنا لا يمتنع أن يكون بيانا ويتقدم على المبين كما نقول في أدلة العقل
يخص بها العموم ويبين بها وإن كانت متقدمة عليه
على أنه يجوز أن يجعل الشيء بيانا لما يرد بعده من الألفاظ ألا ترى أنه
يجوز أن يقول الرجل لغيره إذا قلت لك أعط فلانا عشرة دنانير
فأعطه عشرة دراهم فيجعل هذا دلالة وبيانا لما يرد بعده من الكلام
قالوا ولأن الخاص والعام متضادان كتضاد الحركة والسكون والعلم والجهل
وسائر المعاني ثم كل واحد من هذه المعاني يبطل ما ورد بعده من أضداده
فكذلك الخصوص يبطل بما يوجد بعده من العموم
قلنا لو كان هذا صحيحا لوجب أن يكون ما يرد من العموم يوجب إبطال ما
يقتضيه التخصيص من أدلة العقل اعتبارا بما ذكرتم على أن الحركة والسكون
والعلم والجهل معان متضادة فنافى كل واحد منها ضده فأبطله وليس كذلك هاهنا
فإنها ألفاظ عامة وأدلة خاصة وليس من الألفاظ العامة والأدلة الخاصة تناف
ولهذا يصح وجودهما في النقل والرواية فلم يجز إبطال الأول منهما بالثاني
كالعموم مع أدلة العقل
مسألة 16
يجب بناء العام على الخاص وإن كان العام متفقا على استعماله والخاص مختلفا فيهوقال أصحاب أبي حنيفة العام المتفق على استعماله يقدم على الخاص المختلف فيه
لنا هو أنه تعارض دليلان عام وخاص فبني العام على الخاص دليله إذا اتفق على استعمالهما
ولأن فيما ذكرناه جمعا بين دليلين فكان أولى من إسقاط أحدهما كما لو كانا متفقا عليهما
ولأن الخاص يتناول الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه والعام يتناوله بعمومه لا يجوز أن يكون المراد به غير ما تناوله الخاص فوجب أن يقضى بما لا يحتمل على المحتمل
واحتجوا بأن العام المتفق على استعماله أقوى من الخاص المختلف فيه فوجب تقديمه عليه
قلنا لا نسلم أنه متفق على استعماله في القدر الذي تناوله الخاص منه وإنما هو متفق على استعماله فيما لا يتناوله الخاص بخصوصه وهذا لا يمنع من جواز تخصيصه ألا ترى أن استصحاب الحال في براءة الذمة متفق عليه في الجملة
فيما يتناوله دليل شرعي ثم إذا ورد دليل شرعي نقل عنه وإن كان
الدليل مختلفا فيه
ولأنهم ناقضوا في هذا فإنهم قضوا بالنهي في أكل السمك الطافي وإن كان
مختلفا فيه على قوله صلى الله عليه و سلم أحلت لنا ميتتان ودمان وإن كان
مجمعا عليه
مسألة 17
إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما بني أحدهما على الآخروقال أهل الظاهر إذا تعارض خبران سقطا
لنا هو أنهما لفظان عام وخاص يمكن استعمالهما فوجب استعمالهما وبناء أحدهما على الآخر
دليله الآيتان وذلك مثل قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فقال ابن عباس رضي الله عنه يسألون في موضع ولا يسألون في موضع آخر
ولأنهما دليلان يمكن بناء أحدهما على الآخر فوجب استعمالهما ولا يجوز إسقاطهما
دليله عموم خبر الواحد إذا ورد مخالفا لدليل العقل
فإن قيل أدلة العقل لا تحتمل التأويل والظاهر يحتمل التأويل فرتب وفي مسألتنا تأويل كل واحد من اللفظين كتأويل الآخر فلم يكن أحدهما بأولى من الآخر
قلنا هذا يبطل بالآيتين فإنهما مستعملتان وإن كان تأويل أحدهما
كتأويل الأخرى ويدل عليه أن ما زاد من العموم على الخصوص لا يعارضه مثله
ولا ما هو أقوى منه فوجب أن لا يتوقف فيه كما لو روي في أحد الخبرين ما في
الآخر وزيادة حكم
واحتجوا بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
وهذا التعارض اختلاف فدل على أنه ليس من عند الله
قلنا لا نسلم أن بينهما اختلافا بل هما متفقان عند البناء والترتيب
وعلى أنه لو كان هذا الاختلاف يوجب أن لا يكون ذلك من عند الله لوجب أن
يقال مثل ذلك في الآيات إذا تعارضت ولما أجمعنا على أن ذلك لا يعد اختلافا
في الآيات لإمكان البناء كذلك في الإخبار
قالوا ولأنه إذا تعارض لفظان وأمكن فيه وجهان من الاستعمال كنهيه عن
الصلاة في أوقات النهي وأمره في القضاء لمن نام عن صلاة أو نسيها لم يكن
أحد الوجهين في الاستعمال بأولى من الآخر فوجب إسقاط الجميع
قلنا نحن إنما نستعملهما إذا أمكن وجها واحدا في الاستعمال فأما إذا أمكن
وجهان لم يقدم أحد الوجهين على الآخر إلا بضرب من الترجيح
قالوا لأن البناء والجمع إنما يكون بنفس اللفظ واللفظ لا يدل عليه أو
بدليل آخر وليس معكم في الجمع دليل فوجب التوقف فيه
قلنا هذا يبطل ببناء أحد الآيتين على الآخر فإنه يجوز وإن لم يدل عليه
اللفظ ولا دليل آخر يقتضي الجمع بينهما
وعلى أن الدليل اقتضى الجمع بينهما قد دل على وجوب العمل بكل
واحد من الدليلين وكلام صاحب الشرع لا يتناقض فلم يبق إلا الجمع والترتيب
قالوا ولأنه يحتمل أن يكون أحدهما منسوخا بالآخر ويحتمل أن يكون مرتبا
عليه فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر كما لو احتمل وجهين من الترتيب لا
مزية لأحدهما على الآخر
قلنا هذا يبطل بالآيتين فإنه يحتمل أن تكون إحداهما منسوخة بالأخرى ويحتمل
أن تكون مرتبة عليها ثم قدمنا الاستعمال والبناء على النسخ ولم يجعل ذلك
بمنزلة آيتين تعارض فيهما ترتيبان مختلفان
ولأنه وإن احتمل النسخ إلا أن الترتيب والبناء أظهر لأن فيه استعمال دليل
والنسخ إسقاط دليل والاستعمال أولى لأن الخبر إنما ورد للاستعمال والظاهر
بقاء حكمه
قالوا ولأن أدلة الشرع فروع لأدلة العقل ثم التعارض في أدلة العقل لا
يقتضي الترتيب فكذلك التعارض في أدلة الشرع
قلنا الترتيب في أدلة العقل لا يمكن لأنها لا تحتمل التأويل فهي بمنزلة
نصين تعارضا وفي مسألتنا يحتمل أحد اللفظين التأويل وأن يكون المراد به
بعض ما تناوله الآخر فجاز فيه البناء والترتيب ولهذا المعنى جوزنا الترتيب
في الآيتين ولم يجز ذلك في أدلة العقل
قالوا ولأن الشهادتين إذا تعارضتا سقطتا فكذلك الخبران
قلنا إن أمكن استعمال الشهادتين استعملناهما وهي إذا شهد شاهدان بمائة
وشهد آخران بقضاء خمسين منها فيجمع بينهما كما يجمع بين الخبرين وإن لم
يمكن سقطتا كالخبرين إذ لم يمكن استعمالهما
مسائل الاستثناء
مسألة 1
لا يصح الاستثناء إلا إذا اتصل الكلاموروي عن ابن عباس أنه قال يصح الاستثناء إلى سنة
وروي عن الحسن وعطاء أنه يصح ما دام المجلس
لنا هو أن أهل اللسان لا يسمون ما انفصل عن الكلام وتراخى عنه استثناء في
عرفهم وعادتهم
ألا ترى أنه لو قال رأيت الناس ثم قال بعد شهر إلا زيدا لكان ذلك لغوا فدل
على أن ذلك لا يجوز
ولأنه لو جاز هذا لم يوثق بأحد في وعد ولا وعيد لجواز أن يستثنى بعد زمان
ما يسقط حكم الكلام وفي اتفاق أهل اللسان على خلاف هذا دليل على بطلان هذا
القول
ولأن من جوز الاستثناء إلى سنة لم ينفصل عن من جوزه إلى سنتين وثلاث فوجب
أن يكون الجميع باطلا
واحتجوا بأنه تخصيص عموم فجاز أن يتأخر عن العموم كالتخصيص بغير
الاستثناء
قلنا لا نسلم الأصل على قول من لم يجوز من أصحابنا تأخير البيان عن وقت
الخطاب
فإن سلمنا ذلك فإنا نقلب عليهم فنقول تخصيص عموم فاستوى فيه السنة وما زاد
دليله التخصيص بغير الاستثناء
مسألة 2
الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون استثناء حقيقةوقال بعض أصحابنا يكون حقيقة وهو قول بعض المتكلمين
لنا هو أنه أحد ما يختص به اللفظ العام فلم يصح فيما لم يدخل في العموم كالتخصيص بغير الاستثناء
ولأنه قيل إن الاستثناء مأخوذ من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه وثنيت عنان الدابة إذا صرفتها
وقيل إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر وهذا لا يوجد إلا فيما دخل في الكلام حتى يثنيه على القول الأول ويثني فيه الخبر على القول الثاني
ولأن ألفاظ الاستثناء كقوله إلا وغير وسوى لا تستقل بأنفسها ولا
يصح الابتداء بها فدل على أنه يتعلق بالمستثنى منه وليس لتعلقه به وجه
أكثر من أنها تخرج بعض ما اقتضاه
ولأنه يقبح في الكلام أن يقال خرج الناس إلا الحمير ورأيت الناس إلا
الكلاب فدل على أنه ليس بحقيقة
واحتجوا بأن الاستثناء من غير جنسه لغة العرب والدليل عليه قوله تعالى
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس وقال تعالى فإنهم عدو لي إلا رب
العالمين وهذا كله استثناء من غير الجنس
وقال الشاعر ... وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس ...
فاستثنى اليعافير والعيس من الأنيس
وقال الآخر ... ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب
والفلول من قراع الكتائب ليس بعيب وقد استثناه من العيب
والجواب هو أنه قوله سبحانه فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استثناء
من جنسه لأن إبليس من جنس الملائكة
فإن قيل فكيف يكون من جملتهم وقد قال إنه من الجن
قيل روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هو من جملة الملائكة
وقيل إنه كان من خزان الجنة وكان رئيسهم وإنما سمي بذلك اشتقاقا من الجنة
فبطل ما قالوه
وأما قوله إلا رب العالمين فالمراد به لكن رب العالمين
وأما قول الشاعر ... إلا اليعافير ولا العيس ...
فهو استثناء من جنسه لأن ذلك كله مما يستأنس به
وأما قوله ولا عيب فيهم فهو أيضا استثناء من جنسه لأن الفلول عيب في نفسه وإن كان قد جعل ذلك نسيبا يمدح به قراع الكتائبمسألة 3
يصح الاستثناء الأكبر من الجملةوقال أحمد لا يصح استثناء النصف فما زاد عليه وبه قال ابن درستويه
لنا قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من
الغاوين ثم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين
فاستثنى الغاوين من العباد والعباد من الغاوين وأيهما كان أكثر فقد
استثناه من الآخر فدل على جوازه
ولأنه معنى يخرج من العموم ما لولاه لدخل فجاز في الأكثر كالتخصيص ولأنه
استثناء بعض ما اقتضاه العموم فصح كالأقل
واحتجوا بأن طريق الاستثناء اللغة ولم يسمع ذلك في الأكثر فوجب أن لا يجوز
قلنا لا نسلم بل قد سمع ذلك في اللغة قال الشاعر ... أدوا التي نقضت تسعين
من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا ...
وهذا في معنى الاستثناء لأنه تقديره مائة إلا تسعين
ولأنه وإن لم يسمع من أهل اللغة إلا أن القرآن قد نزل به على ما بيناه
والقرآن أقوى ما رجع إليه في معرفة اللغة
ولأنه لو لم يسمع لكان ذلك في معنى المسموع لأن القصد من الاستثناء
الاستدراك على نفسه فيما أورده من القول وذلك موجود في القليل والكثير
فكان حكم أحدهما كحكم الآخر يبين صحة هذا هو أنا لم نسمع منهم الاستثناء
في كل جنس وفي كل عدد لكن لما عرفنا غرضهم فيما سمعناه من كلامهم حملنا
عليه كل عدد وكل جنس فكذلك هاهنا
قالوا ولأن كلام العرب موضوع على الاختصار وليس من الاختصار أن يقول له
علي عشرة إلا تسعة ونصفا ويمكنه أن يقول علي نصف درهم
قلنا هم يبسطون الكلام تارة ويختصرونه أخرى ولهم بالجميع عادة فلا يجوز
إسقاط إحدى العادتين بالأخرى
ولأنه لو كان في هذا دليل على أنه لا يجوز استثناء الأكثر لم
يجز أن يجعل دليلا على أنه يجوز استثناء الأقل لأنه ليس من الاختصار أنه
يجمع بين النفي والإثبات ويذكر عددين فيقول علي عشرة إلا أربعة ويمكنه أن
يقتصر على الإثبات فيقول له علي ستة ولما أجمعنا على جواز ذلك دل على
بطلان ما قالوه
قالوا ولأن عادة العرب في الكلام إذا ضموا مجهولا إلى معلوم أن يبنوا
الأمر على التقريب فإذا كان المجهول قريبا من العقد ذكروا العقد واستثنوا
المجهول وإن كان بعيدا منه ضموه إلى ما قبله من العدد ولم يستثنوه فيقولون
فيما قرب من العقد كران إلا شيئا وفيما بعد من العقد كر حنطة وشيء ولهذا
حمل الشافعي رحمه الله قول ابن جريج في تقدير القلة بالقربتين وشيء الشيء
على دون النصف ثم بلغ به النصف احتياطا للماء فدل على أنه لا يستثني إلا
الأقل
قلنا هذا هو الدليل عليكم لأنهم إذا ضموا مجهولا إلى عقد ثم فسر ذلك بما
يقارب العقد الثاني جاز وهو أن يقول له علي كر وشيء ثم يفسر الشيء بأكثر
من النصف
وإن كانت العادة أن لا يضم المجهول إلى العقد الأول إلا إذا كان أقل من
النصف فكذلك يجوز استثناء المجهول من العقد الثاني ثم يفسر ذلك
بما زاد على النصف وإن كانت العادة فيه خلاف ذلك
ولأنه لو كان جواز الاستثناء يعتبر بما يعتادونه من كلامهم من ضم المجهول
إلى الجملة واستثنائه منها لوجب أن لا يجوز استثناء الشيء اليسير من
الجملة فإنهم لا يقولون في العادة علي عشرة إلا شيئا ويريدون به استثناء
أربعة منها ولما أجمعنا على جواز استثناء أربعة من العشرة دل على بطلان ما
ذكروه
مسألة 4
إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع الاستثناء إلى الجميع وقال أصحاب أبي حنيفة يرجع إلى أقرب المذكور فقط
وقال الأشعرية هو موقوف على الدليل
لنا هو أن الاستثناء معنى يقتضي التخصيص لا يستقل بنفسه فإذا تعقب جملا
رجع إلى الجميع كالشرط وهو إذا قال امرأتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن
شاء الله كان هذا الشرط يرجع إلى الجميع فكذلك الاستثناء
ولأن ما جاز أن يرجع إلى كل واحدة من الجمل إذا انفردت عاد إلى جميعها إذا
عطف بعضها على بعض كالشرط الذي ذكرناه ويبين صحة هذا هو أن الاستثناء في
معنى الشرط ألا ترى أنه لا فرق بين قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
إلا الذين تابوا وبين قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إن لم يتوبوا
وإنما اختلف لفظهما فإذا رجع الشرط إلى الجميع وجب أن يرجع الاستثناء إلى
الجميع
ولأنه يصلح عوده إلى كل واحدة من الجمل وليس بعضها بأولى من
البعض فوجب أن يرجع إلى الجميع كالعموم لما صلح لفظه لكل واحد من الجنسين
ولم يكن بعضهما بأولى من البعض حمل على الكل كذلك هاهنا
ولأن المعطوف بالواو كالمذكور جملة واحدة يدلك عليه هو أنه لا فرق بين أن
يقول اقتلوا اليهود والنصارى والمجوس وبين أن يقول اقتلوا المشركين
ثم ثبت أن الاستثناء إذا تعقب المذكور جملة عامة رجع إلى الجميع مثل أن
يقول اقتلوا المشركين إلا من أدى الجزية فكذلك إذا أفرد بعضها عن بعض وعطف
بالواو
فإن قيل فرق بين المذكور جملة واحدة وبين المعطوف بالواو ألا ترى لو قال
لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة يصح استثناؤه ولو قال أنت طالق وطالق
وطالق إلا تطليقة لم يصح
قلنا هذه المسألة فيها وجهان فلا نسلم على أحدهما
وإن سلمنا فلأن هناك لا يجوز أن ترد إلى كل واحد من الجملة عند الانفراد
فكذلك لا يجوز عند الاجتماع وفي مسألتنا بخلافه
فإن قيل إذا ذكر جملة عامة ثم استثناء لم يفصل بين الاستثناء والمستثنى
منه بما يمنع الرجوع وإذا عطف بعضها على بعض فقد فصل بين الاستثناء
والجملة الأولى بما يمنع الرجوع وهو الجملة المعطوفة
قيل الواو تقتضي الجمع والتشريك والمذكور بالعطف كالمجموع بلفظ عام فإذا
رجع الاستثناء في أحدهما إلى الجميع فكذلك في الآخر
واحتجوا بأنه فصل بالجملة الثانية بين الجملة الأولى وبين
الاستثناء فلم يرجع الاستثناء إليهما كما لو فصل بينهما بقطع الكلام
وإطالة السكوت
قلنا الفصل بين الجملة والاستثناء بالكلام لا يمنع من عود الاستثناء وإن
كان الفصل بالإطالة والسكوت يمنع ألا ترى أنه لو فصل بين الجملة
والاستثناء بالخبر بأن يقول أعط بني تميم وبني طيء كل واحد دينارا إلا
الكفار لم يمنع ذلك من رجوع الاستثناء إلى الجميع ولم يجعل ذلك بمنزلة ما
لو فصل بينهما بالسكوت
قالوا ولأنه استثناء تعقب جملتين فلم يرجع بظاهره إليهما كما لو قال أنت
طالق ثلاثا ثلاثا إلا أربعا
قلنا إنما يرجع فيما ذكروه إلى الجميع لأن الاستثناء يرفع المستثنى منه
وهاهنا لا يرفع المستثنى منه يدلك عليه أن فيما ذكروه لو انفردت كل واحدة
من هذه الجمل وتعقبها الاستثناء لم يرجع إليها وهاهنا لو انفردت كل واحدة
من هذه الجمل وتعقبها الاستثناء رجع إليها فدل على الفرق بينهما
قالوا ولأن العموم قد ثبت في كل واحدة من هذه الجمل وتعقبها الاستثناء
وتخصيص جميعها بالاستثناء مشكوك فيه فلا يجوز تخصيص العموم بالشك
قلنا لا نسلم ثبوت العموم مع اتصال الاستثناء بالكلام ثم هذا يبطل بالجملة
الواحدة إذا تناولت أشياء ثم تعقبها استثناء بأن العموم قد ثبت لكل واحدة
من الجمل على زعمهم ثم الاستثناء يعود إلى الجميع
وعلى أنا نعارضهم بمثله فنقول القدر الذي حصل عليه الوفاق أصل داخل في
عموم الجملتين بيقين وهو لم يتناوله الاستثناء بالإجماع وما زاد عليه
مشكوك فيه فلا يحمل اللفظ عليه بالشك
قالوا ولأن الاستثناء إنما رد إلى ما تقدم لأنه لا يستقل بنفسه
فإذا رد إلى ما يليه استقل فلم تجز الزيادة عليه إلا بدليل
قلنا هذا باطل بالشرط فإنه إنما علق على ما يتصل به من الكلام لأنه لا
يستقل بنفسه وإذا رد إلى ما يليه استقل ثم لا يقتصر عليه
قالوا لأنه لو قال امرأتي طالق وأعط فلانا عشرة دراهم إن دخل الدار لم
يرجع إلى الطلاق فكذلك هاهنا
قلنا فيما ذكرتم عدل عن لفظ الخبر إلى الأمر وقطع حكم الكلام الأول فروعي
حكم الشرط فيما استأنف وليس كذلك في مسألتنا فإنه لم يقطع ما تقدم بغيره
فوزانه من الشرط أن يقول امرأتي طالق ولفلان على عشر دراهم إن دخلا الدار
فيرجع الشرط إلى الجميع
واحتج من ذهب إلى الوقف بأنه يجوز أن يكون عائدا إلى البعض ويجوز أن يكون
عائدا إلى الجميع فوجب التوقف فيه
قلنا هو وإن احتمل أن يكون عائدا إلى البعض إلا أن عوده إلى الكل هو
الظاهر وقد دللنا عليه فوجب حمل الكلام عليه وإن احتمل غيره
مسائل المجمل والمفصل
مسألة 1
في القرآن مجازوقال بعض أهل الظاهر ليس في القرآن مجاز
لنا هو أن المجاز ما تجوز عن موضوعه إما بزيادة أو نقصان أو
تقديم أو تأخير أو استعارة وقد وجد جميع ذلك في القرآن
فالزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء والمراد ليس مثله شيء
والنقصان كقوله واسأل القرية والمراد به أهل القرية
والتقديم والتأخير كقوله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والمراد به
أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء
والاستعارة كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق فعبر عن شدة الحال بكشف الساق لأن
عند الشدائد يكشف عن الساق
وأمثال ذلك في القرآن أكثر من أن يحصى
وقد ألزم أبو العباس بن سريج ابن داود في المناظرة له في قوله تعالى لهدمت
صوامع وبيع وصلوات ومساجد فعبر عن الصلوات بالمساجد لأن الصلوات لا يتأتى
هدمها
وألزمه قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض والإرادة لا تصح من
الجدار فلم يجد عن ذلك محيصا
واحتجوا بأن استعمال المجاز لموضع الضرورة وتعالى الله بأن يوصف بالاضطرار
والجواب أنا لا نسلم أن استعمال المجاز لموضع الضرورة بل ذلك عادة العرب
في الكلام وهو عندهم مستحسن ولهذا تراهم يستعملون ذلك في كلامهم مع القدرة
على الحقيقة والقرآن نزل بلغتهم فجرى الأمر فيه على عادتهم
قالوا القرآن كله حق ولا يجوز أن يكون حقا ولا يكون حقيقة
والجواب أنه ليس الحق من الحقيقة بسبيل بل الحق في الكلام أن يكون صدقا
وأن يجب العمل به والحقيقة أن يستعمل اللفظ فيما وضع له سواء كان ذلك صدقا
أو كذبا ويدل عليه أن قول النصارى الله ثالث ثلاثة وهو حقيقة فيما أرادوه
وقوله عليه السلام لرجاله يا أنجشة ارفق بالقوارير وليس بحقيقة فيما
استعمل فيه وهو صدق وحق فدل على أن أحدهما غير الآخر
مسألة 2
ليس في القرآن شيء غير العربيةوقال بعض المتكلمين في القرآن كلمات بغير العربية كالمشكاة
والقسطاس والسجيل والإستبرق وغير ذلك
لنا قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقوله تعالى ولو جعلناه قرآنا
أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي وهذا نص في أنه ليس فيه غير
العربي
ولأن الله تعالى جعل القرآن معجزة نبيه صلى الله عليه و سلم ودلالة صدقه
ليتحداهم به فلو كان فيه غير العربي لما صح التحدي به لأن الكفار يجدون
إلى رده طريقا بأن يقولوا أن فيما أتيت به غير العربي ونحن لا نقدر على
كلام بعضه عربي وبعضه عجمي وإنما نقدر على معارضة العربي المحض
واحتجوا بأنا وجدنا في كتب الله تعالى ألفاظا بغير العربية كالمشكاة كوة
بالهندبة والإستبرق والسجيل بالفارسية وربما قالوا إن فيه ما لا يعرفه
العرب وهو الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا فدل على أن فيه غير العربي
والجواب أنا لا نسلم فيه كلمات بغير العربية بل كل ذلك بلغة
العرب وإنما وافقتها الفرس والهند في النطق بها كما وافقوا في كثير من
كلامهم فيقولون حراج مكان السراج والشراويل مكان السراويل والفرس يقولون
في السماء اسمان وفي الجبال أوجبا وغير ذلك من الأسماء
والذي يدل عليه هو أن الله تعالى أضاف ذلك إليهم فدل على أنهم سبقوا إلى
ذلك وتبعهم الفرس والهند
وقولهم إن فيه ما لا تعرفه العرب وهو الأب غلط فإن الأب الحشيش فليس إذا
لم يعرفه بعضهم خرج أن يكون ذلك لغة العرب
لأن لغة العرب أوسع اللغات فيجوز أن يخفى بعضها على بعض لكثرتها ولهذا روي
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لم أعلم أن معنى قوله سبحانه فاطر
السموات والأرض حتى سمعت امرأة تقول أنا فطرته فعلمت أنه أراد به منشىء
السموات والأرض
قالوا وأيضا فإن النبي صلى الله عليه و سلم مبعوث إلى الكافة فيجب أن يكون
في الكتاب من كل لغة
قلنا فهذا يقتضي أن يكون فيه من جميع اللغات من الزنجية والتركية والرومية
وفي إجماعنا على خلاف هذا دليل على بطلان ما قالوه
ولأنه لو كان كذلك لكان يجب أن يكون فيه من هذه اللغات قدرا يعلم به
المراد ويقع به التبليغ فأما هذه الكلمات الشاذة فلم يعلم بها شيء ولا يقع
بها بيان
ولأنه وإن كان مبعوثا إلى الكافة إلا أن القصد إعجاز العرب فإنهم أهل
اللسان والفصاحة والبيان فإذا ظهر عجزهم عن الإتيان بمثله دل
على أن غيرهم عن ذلك أعجز وثبت صدقه في حق الجميع وعلى هذا الترتيب أجرى
الله تعالى أمر معجزات الأنبياء فبعث موسى إلى أحذق الناس بالسحر في زمان
كانوا يدعون السحر فجعل معجزته من جنس يدعونه حتى إذا عجزوا عن مثله دل
على أن غيرهم أعجز
وبعث عيسى صلى الله عليه و سلم في زمن الأطباء وجعل معجزته من جنس ما
يتعاطونه حتى إذا اعترفوا بالعجز عن مثله دل على أن غيرهم عن ذلك أعجز
فكذلك هاهنا لما أن كانت العرب في ذلك الزمان أفصح الناس لسانا وأحسنهم
بيانا جعل المعجزة من جنس ما كانوا يدعونه ليكون ذلك أظهر في الإعجاز
وأبين في الدليل
مسألة 3
يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان كالأقراء يراد به الحيض والطهر واللمس يراد به الجماع واللمس باليد وبه قال أبو علي الجبائيوقال أصحاب أبو حنيفة لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان وهو قول أبي هاشم
لنا أن كل معنيين جاز إرادتهما بلفظين جاز إرادتهما بلفظ يصلح
لهما كالمعنيين المتفقين وذلك أن تقول إذا أحدثت فتوضأ تريد به البول
والغائط
ولأن المنع من ذلك لا يخلو إما أن يكون لاستحالة اجتماعهما في الإرادة
كاستحالة العموم والخصوص والإيجاب والإسقاط أو لأن اللفظ لا يصلح لهما ولا
يجوز أن يكون للوجه الأول لأنه لا يستحيل أن يريد بقوله أو لامستم النساء
الملامستين ولا أن يريد بقوله ثلاثة أقراء كلا القرأين ولهذا يصح أن يصرح
بهما فيقول إذا لمست باليد وجامعت فتطهر وإذا طلقت فاعتدي بثلاثة أقراء من
الحيض والطهر
ولا يجوز أن يكون لأن اللفظ لا يصلح لهما لأن اللفظ يصلح لهما إما على
سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز فلم يكن للمنع منه وجه
واحتجوا بأن العبارة الواحدة لا يجوز أن يراد بها ما وضعت له حقيقة وما لم
توضع له حقيقة ولهذا لا يجوز أن يراد بلفظ الأمر الإيجاب والتهديد فكذلك
هاهنا
قلنا هذا يبطل بالماء المذكور في آية التيمم فإن المخالف لنا في هذا حمله
على الماء والنبيذ وهو حقيقة في أحدهما دون الآخر
فأما الإيجاب والتهديد فلا يجوز اجتماعهما في الإرادة في شيء واحد في حالة
واحدة بل عليه أنه لا يصلح أن يصرح بهما جميعا وليس كذلك هاهنا فإنه يصلح
اجتماعهما في الإرادة على ما بيناه واللفظ يصلح لهما فصح إرادتهما
كالمعنيين المتفقين
قالوا ولأنه لو جاز أن يراد بلفظ واحد معنيان مختلفان لجاز أن يراد باللفظ
الواحد تعظيم الرجل والاستخفاف به ولما لم يجز ذلك لم يجز هذا
قلنا التعظيم والاستخفاف معنيان متضادان ولا تصح إرادتهما باللفظ
الواحد ولهذا لو صرح بما يقتضي الاستخفاف والتعظيم في حالة
واحدة لما صح وليس كذلك هاهنا فإنهما لا يتضادان في الإرادة ألا ترى أنه
لو صرح بهما في لفظين جاز ذلك فبان الفرق بينهما
قالوا ولأن طريق هذا اللغة ولم نر أهل اللغة استعملوا اللفظ الواحد في
معنيين مختلفين في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا وفي أحدهما صريحا وفي
الآخركناية فدل على أن ذلك لا يجوز
قلنا لا نسلم فإن ذلك في الاستعمال ظاهر ألا ترى أنه يصح أن يقول من لم
يلمس امرأته فلا طهر عليه ويريد به نفي جنس اللمس في الجماع وما دونه وإذا
صح ذلك في النفي صح في الإثبات إذ لا فرق بينهما
ويدل عليه أنه يجوز أن يقول نهيتك عن مسيس النساء ويريد به اللمس باليد
والجماع وإن كان لمعنيين مختلفين فدل أن ذلك جائز
مسألة 4
العموم إذا دخله التخصيص لم يصر مجملا ويصح الاحتجاج به فيما بقي من اللفظ وبه قال بعض أصحاب أبي حنيفة وهو قول المعتزلةوقال عيسى بن أبان إذا دخله التخصيص صار مجملا فلا يجوز التعلق بظاهره وحكى ذلك عن أبي ثور
وقال أبو الحسن الكرخي إذا خص بالاستثناء أو بكلام متصل
صح التعلق به وإن خص بدليل منفصل لم يصح التعلق به وقال أبو عبد
الله البصري إن كان الحكم الذي يتناوله العموم يحتاج إلى شرائط وأوصاف لا
ينبىء اللفظ عنها كقوله تعالى والسارق والسارقة صار مجملا وجرى في الحاجة
إلى البيان مجرى قوله تعالى وأقيموا الصلاة فلا يحتج به إلا بدليل
لنا أن فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقوله
تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ولم ينكر أبو بكر ولا
أحد من الصحابة احتجاجها بالآية وإن كان قد دخلها التخصيص في الرقيق
والكافر والقاتل
ولأنه لو كان دخول التخصيص في اللفظ يمنع الاحتجاج به لوجب التوقف في
كل ما يرد من ألفاظ العموم لأنه ما من خطاب إلا وقد اعتبر في
إثبات حكمه صفات في المخاطب من تكليف وإيمان وغير ذلك فيؤدي ذلك إلى قول
أهل الوقف وقد أجمعنا على بطلان قول أهل الوقف
فإن قيل أنتم أيضا توقفتم في العموم على تعرف ما يوجب تخصيصه ولم يصر ذلك
في معنى قول أهل الوقف
قلنا نحن نتوقف في الخطاب إلى غاية وهو إلى أن ينظر في الأصول فإذا لم نجد
ما يخصصه حملناه على العموم وأنتم تتوقفون في كل ما يرد من العموم فلا
تعملون به إلا بأدلة فصار ذلك كقول أهل الوقف
وأما الدليل على البصري فهو أن المجمل ما لا يعقل المراد من لفظه وما يراد
بآية السرقة معقول من ظاهر اللفظ فصار بمنزلة قوله اقتلوا المشركين
ولأن هذا الخطاب لو حملناه على ظاهره لم نخطىء إلا في ضم ما لم يرد على ما
أريد فإذا بين ما لم يرد بقي على ظاهره في الباقي فوجب المصير إليه والعمل
به كما تقول في سائر العمومات
واحتجوا بأن هذا مبني على أصلنا وهو أن العموم إذا خص صار مجازا وقد دللنا
عليه في موضعه فإذا ثبت هذا لم يكن حمله على بعض الوجوه بأولى من البعض
فوجب أن يفتقر إلى البيان
والجواب أنا لا نسلم هذا الأصل وقد بينا الكلام عليه في موضعه
فأغنى عن الإعادة
قالوا ولأنه إذا دخله التخصيص لم يوجب حكمه فبطل الاحتجاج به كما قلتم في
العلل
والجواب هو أنه لو كان هذا دليلا علينا فهو دليل عليكم فإن تخصيص العلل لا
يمنع الاحتجاج بها عندهم فيجب أن يكون تخصيص العموم لا يمنع من الاحتجاج
به
وعلى أن عندنا إنما لم يجز الاحتجاج بما خص من العلل لأنها تظهر من جهة
المستدل ولا يعلم صحتها إلا بدليل ولا شيء يدل عليه إلا السلامة والجريان
وليس كذلك العموم فإنه يظهر من جهة صاحب الشرع فلا يحتاج في صحته إلى دليل
فافترقا
قالوا ولأنه إذا دخل التخصيص صار كأنه أورد لفظ العموم ثم قال أردت به بعض
ما يتناوله وما هذا سبيله لا يحتج به فيما أريد به كما تقول في قوله تعالى
إن بعض الظن إثم فإنه لا يعلم من لفظه ما فيه إثم إلا بدليل
قلنا إنما لم يعلم المراد من الآية التي ذكروها لأنه علق ذلك على بعض
مجهول فاحتيج في معرفته إلى دليل آخر وفي مسألتنا علق الحكم على لفظ يعلم
منه الجنس فإذا تبين ما ليس بمراد بقي الباقي على ظاهره
واحتج البصري بأن آية السرقة لا يمكن العمل بها حتى تنضم إليها شرائط لا
ينبىء اللفظ عنها والحاجة إلى بيان الشرائط التي يتم بها الحكم كالحاجة
إلى بيان الحكم وقد ثبت أن ما يفتقر إلى بيان الحكم مجمل كقوله تعالى
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فكذلك ما يفتقر إلى شرائط الحكم
والجواب أن هذا يبطل بقوله فاقتلوا المشركين فإنه لا يمكن العمل
بها حتى ينضم إليها شرائط لا ينبىء اللفظ عنها كالعقل والبلوغ وغير ذلك ثم
لا يجعل الحاجة إلى ذلك كالحاجة إلى بيان المراد في الإجمال
فإن قيل تلك الآية إنما تفتقر إلى بيان من لا يراد بها من الصبيان
والمجانين فحملت في الباقي على ظاهرها وهاهنا تفتقر إلى بيان ما أريد
بالآية من شرائط القطع ولهذا اشتغل الفقهاء بذكر شرائط القطع دون ما يسقط
القطع فافترقا
قيل لا فرق بين الموضعين فإن آية السرقة أيضا تفتقر إلى بيان ما لا يراد
وهو من سرق دون النصاب أو سرق من غير حرز أو كان والدا أو ولدا
وأما ما ذكر الفقهاء فيه شرائط القطع فلا اعتبار به فإنهم يسلكون في ذلك
طريق الاختصار فيذكرون الشرائط التي يتعلق بها القطع لتعرف بذلك من لا يجب
عليه القطع وإنما الاعتبار بما يقتضيه اللفظ وما أخرج منه ومعلوم أن
الظاهر يقتضي وجوب القطع على كل من سرق ودل الدليل إنما دل على إخراج من
ليس بمراد من صبي أو مجنون ووالد وولد وغير ذلك فصار ذلك بمنزلة ما ذكرناه
من آية القتل التي تقتضي بظاهرها إيجاب القتل على كل مشرك ثم دل على
الدليل على من ليس بمراد منها
وأما قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ففيه وجهان من أصحابنا من
قال هي عامة فتحمل على كل دعاء إلا ما أخرجه الدليل ومنهم من قال إنها
مجملة وتفتقر إلى بيان فعلى هذا الفرق بينهما أن المراد بالصلاة لا يصلح
له اللفظ ولا يدل عليه وما يراد بالسارق يصلح له اللفظ في اللغة ويعقل منه
ألا ترى أنه إذا أخرج من آية السرقة من لا يراد قطعه أمكن قطع من أريد
قطعه بظاهر الآية وإذا أخرج من آية الصلاة من ليس بمراد لم يمكن
أن يحمل على المراد بالآية فافترقا
وربما احتج بأن القطع يحتاج إلى أوصاف سوى السرقة من النصاب والحرز وغير
ذلك فصار بمنزلة ما لو احتاج إلى فعل غير السرقة ولو افتقر إيجاب القطع
إلى فعل غير السرقة لم يمكن التعلق بظاهره فكذلك إذا افتقر إلى أوصاف سوى
السرقة
والجواب هو أن هذا يبطل بآية القتل فإنها تفتقر إلى أوصاف غير الشرك
كالبلوغ والعقل وغير ذلك ثم لا يضر ذلك بمنزلة ما لو احتاج القتل إلى فعل
آخر في إجمال الآية والمنع من التعلق بها ويخالف هذا إذا افتقر الحكم إلى
فعل آخر فإن هناك لو خلينا وظاهر الآية لم يمكن لنفيد شيئا من الأحكام
فافتقر أصلها إلى البيان وهاهنا لو خلينا والظاهر لم نخطىء إلا في ضم ما
لم يرد إلى ما أريد باللفظ فعلمنا أنه ظاهر في الباقي
مسألة 5
يصح الاحتجاج بعموم اللفظ وإن اقترن بذكر المدح أو الذم كقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليموقال بعض أصحابنا إذا قرن بذكر المدح أو الذم صار مجملا فلا يحتج بعمومه
لنا هو أن صيغة العموم قد وجدت متجردة عن دلالة التخصيص فأشبه إذا تجردت عن ذكر المدح أو الذم
ولأن اقتران المدح به لا ينافي القصد إلى بيان الحكم فلم يمنع التعلق بعمومه كاقتران حكم آخر به
ولأن اقتران المدح به يؤكد حكم الإباحة واقتران الذم يؤكد حكم
التحريم فهو بجواز الاحتجاج به أولى
ولأنه لو كان اقتران ذكر المدح به يمنع من حملها على العموم لكان اقتران
ذكر العقاب به يمنع من ذلك وهذا يؤدي إلى إبطال التعلق بآية السرقة والربا
وغيرهما من العمومات
واحتجوا بأن القصد من هذه الآيات المدح والذم على الفعل دون بيان ما يتعلق
به الحكم من الشرائط والأوصاف فلا يجوز التعلق بعمومها فيما يستباح وفيما
تجب فيه الزكاة كما قلنا في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده لما كان القصد
بهذا بيان إيجاب حق من الزرع لم يجز الاحتجاج بعمومه بالمقدار والجنس
والجواب هو أن لا نسلم أن القصد بها هو المدح دون الحكم بل القصد بها بيان
الجميع لأن المقاصد إنما تعلم بالألفاظ وقد وجدنا اللفظ فيهما والظاهر أنه
قصدهما
ولأنه لو جاز أن يقال أن ذكر المدح يمنع من كون الحكم مقصودا جاز أن يقلب
ذلك عليهم فيقال أن ذكر الحكم يمنع كون المدح مقصودا وهذا باطل بالإجماع
فبطل ما قالوه
مسألة 6
الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج أسماء منقولة من اللغة إلى معان وأحكام شرعية إذا أطلقت حملت على تلك الأحكام والمعانيومن أصحابنا من قال إنه لم ينقل شيء من ذلك عما وضع له اللفظ في اللغة وإنما ورد الشرع بشرائط وأحكام مضافة إلى ما وضع له اللفظ في اللغة وهو قول الأشعرية
لنا هو أن هذه الأسماء إذا أطلقت لم يعقل منها إلا هذه العبادات
في الشرع ولهذا يقال أحرم فلان بالصلاة إذا كبر وأحرم بالحج إذا نوى الحج
وإن لم يأت بشيء مما وضع له الاسم في اللغة
ويدل عليه هو أنه لو كانت الصلاة عبارة عما وضع له اللفظ في اللغة من
الدعاء لوجب إذا عرى عن ذلك أن لا تسمى صلاة ولما أجمعنا على تسمية صلاة
الأخرس صلاة وإن لم يأت فيها بشيء من الدعاء دل على أنه اسم منقول
ويدل عليه هو أن الزكاة في اللغة هي الزيادة والنماء ولهذا يقول العرب إذا
كثرت المؤتفكات زكى الزرع أي إذا كثرت الرياح زاد الزرع ثم جعل في الشرع
اسما لإخراج جزء من المال وذلك في الحقيقة نقصان وليس بزيادة فدل على أنه
منقول
وأيضا هو أنه لما حدث في الشرع عبادات وهيئات وأفعال ولم يكن لها اسم في
اللغة دعت الحاجة إلى أن يوضع لها اسم في الشرع يعرف بها كما وضع أهل
الصنائع لكل ما استحدثوه من الأدوات اسما يعرفونها به عند الحاجة إلى
ذكرها
واحتجوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا وبقوله سبحانه ما أرسلنا من
رسول إلا بلسان قومه والصلاة بلسان العرب هي الدعاء والصوم هو الإمساك
والحج هو القصد فإذا ورد الشرع وجب أن تحمل على ما يقتضيه لسان العرب
والجواب هو أن هذه الآيات تقتضي أنه خاطبها بلسان العرب ونحن نقول بذلك
لأن هذه الأسماء كلها عربية والخطاب بها خطاب بلغة العرب وليس إذا استعمل
ذلك في غير ما وضعته العرب يخرج عن أن يكون خطابا بلسان العرب ألا ترى أن
الحمار قد استعمل في غير ما وضعه العرب وهو الرجل البليد والبحر في
غير ما وضعته العرب وهو الرجل الجواد ولا يخرج الخطاب بذلك عن
أن يكون خطابا بلسان العرب فكذلك هاهنا
قالوا ولأنه لو كان في الأسماء شيء منقول لبينه النبي صلى الله عليه و سلم
بيانا يقع به العلم ولو فعل ذلك لعلمناه كما علمتم ولما لم يعلم ذلك دل
على أنه لم ينقل
قلنا قد بين النبي صلى الله عليه و سلم ذلك بيانا تاما ألا ترى أن كل موضع
ذكر الصلاة لم يرد به إلا هذه الأفعال ولكن ليس من شرط البيان أن يقع به
العلم لكل أحد ألا ترى أنه بين الحج بيانا تاما ثم لم يقع العلم به لكل
أحد حتى اختلف العلماء في إحرامه فقال بعضهم كان مفردا وقال بعضهم كان
قارنا فكذلك هاهنا
مسألة 7
قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آية مجملة وكذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاومن أصحابنا من قال هي عامة فتحمل الصلاة على كل دعاء والحج على كل قصد إلا ما أخرجه الدليل
لنا هو أن المجمل مالا يعقل معناه من لفظه وهذه الآيات لا يعقل معناها من لفظها لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء والزكاة هي الزيادة والحج هو القصد والمراد بذلك هي أفعال مخصوصة لا ينبىء اللفظ عنها فكان مجملا كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده
واحتجوا بأن الصلاة هي الدعاء في اللغة والزكاة هي الزيادة
والحج هو القصد فوجب أن تحمل الصلاة على كل دعاء والزكاة على كل زيادة
والحج على كل قصد إلا ما خصه الدليل كسائر العمومات
والجواب أنا قد ذكرنا فيما تقدم أنه ليس المراد بالصلاة الدعاء ولا
بالزكاة الزيادة ولا بالحج القصد وإنما المراد بها معان أخر لا ينبىء
اللفظ عنها فلا يصح حملها على العموم فيما ليس بمراد
مسألة 8
قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا آية عامة يصح الاحتجاج بظاهرهاومن أصحابنا من قال هي مجملة
لنا أن البيع معقول في اللغة وما كان معقول المراد من لفظه في اللغة لم يكن مجملا كقوله تعالى اقتلوا المشركين
واحتج المخالف بأن الله تعالى حكاه عن العرب وهم أهل اللسان بأن البيع مثل الربا ثم أحل الله البيع وحرم الربا فصار الحلال مشتبها بالحرام فافتقر إلى البيان
والجواب أنهم وإن شبهوا البيع بالربا إلا أن البيع متميز عن الربا فإن الربا هو الزيادة وذلك لا يوجد في كل بيع فوجب أن يحمل قوله تعالى وأحل الله البيع على كل بيع إلا ما أخرجه الدليل
قالوا ولأن قوله تعالى وأحل الله البيع يقضي إحلال البيع والبيع يجوز في أشياء مع التفاضل وقوله وحرم الربا يقتضي تحريم التفاضل فأجملت إحدى اللفظتين بالأخرى
والجواب هو أن هذا بيان تخصيص دخل في الآية ومتى كان اللفظ معقول المراد في اللغة لم يجز أن يصير مجملا بدخول التخصيص فيه فكذلك هاهنا ألا ترى أن قوله تعالى فاقتلوا المشركين لما كان معقول المراد في اللغة لم يصر مجملا بدخول التخصيص فيه فكذلك هاهنا
مسألة 9
الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على الأعيان كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة و حرمت عليكم أمهاتكم ظاهرة في تحريم التصرف وليست بمجملةومن أصحابنا من قال هي مجملة فلا يجوز الاحتجاج بها وهو قول أبي عبدالله البصري من أصحاب أبي حنيفة
لنا هو أن التحريم إذا أطلق في مثل هذا فهم منه تحريم الأفعال في اللغة والدليل عليه هو أنه لما بلغ الصحابة رضي الله عنهم تحريم الخمر أراقوها وكسروا ظروفها ولما أباح النبي صلى الله عليه و سلم الانتفاع بإهاب الميتة قيل له إنها ميتة فقال إنما حرم من الميتة أكلها فدل على أنهم فهموا من تحريم الميتة تحريم الانتفاع بها
ويدل عليه هو أن رجلا لو قال لغيره أبحت لك طعامي أو حرمت عليك
طعامي فهم المخاطب منه تحريم الانتفاع به والتصرف فيه وما فهم المراد من
لفظه في اللغة لم يكن مجملا كسائر الظواهر
وأيضا هو أنه لا خلاف لو علق حكما على ما ملكه الإنسان من الأعيان كقوله
تعالى أو ما ملكت أيمانكم لم يكن مجملا وإن كان لا يملك إلا الأفعال في
الأعيان والتصرف فيها بالمنافع ودفع المضار ولكن لما تعورف استعمال هذه
الألفاظ في التصرف المعروف في المال حمل إطلاقه عليه فكذلك هاهنا
واحتجوا بأن الأعيان لا تدخل في المقدور لأنها موجودة كائنة وما لا يدخل
في المقدور لا يجوز أن يقع التعبد به فوجب أن يكون التحريم فيها راجعا إلى
الأفعال التي تدخل تحت المقدور وذلك غير مذكور فجرى مجرى قوله واسأل
القرية
والجواب هو أن هذا يبطل بملك الأعيان فإن الأعيان لا تدخل في ملك المقدور
على ما ذكروه وما لا يدخل في المقدور لا يجوز أن يملكه الإنسان ثم إذا
أطلق لفظ الملك حمل على ما يتعارف من التصرف ويخالف هذا قوله وسأل القرية
لأن القرية لا يعبر بها عن أهلها في العرف والعادة وليس كذلك الأعيان
فإنها تستعمل في موضع الأفعال في عرف أهل اللسان فصار كسائر الحقائق
قالوا ولأن أنواع التصرف في العين كثيرة والحمل على الجميع لا يجوز لأنها
دعوى فيما لا ذكر له والعموم من صفات اللفظ والحمل على البعض لا يجوز لأنه
ليس بعضها بأولى من بعض فوجب التوقف فيه حتى يرد البيان
والجواب أن هذا يبطل بما ذكرناه من ملك العين فإن ما يملك من العين كثير
والحمل على الجميع دعوى فيما لا ذكر له ثم كان اللفظ ظاهرا في بيانه
مسألة 10
إذا علق النفي في شيء على صفة كقوله صلى الله عليه و سلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقوله لا نكاح إلا بولي و إنما الأعمال بالنيات وغير ذلك من الألفاظ التي تستعمل في نفي وإثبات أو رفع وإسقاط حمل ذلك على نفي الشيء ومنع الاعتداد به في الشرعومن أصحابنا من قال إن ذلك مجمل فلا يحمل على شيء إلا بدليل وهو قول البصري من أصحاب أبي حنيفة
لنا هو أن هذا اللفظ عند أهل اللسان موضوع للتأكيد في نفي
الصفات ورفع الأحكام
ألا ترى أنه يقال ليس في البلد سلطان وليس في الناس ناظر وليس لهم مدبر
والمراد في ذلك كله نفي الصفات التي تقع بها الكفاية ومنع الاعتداد به
فيما لهم من الأمور
وإذا كان هذا مقتضاه وجب إذا استعمل ذلك في عبادة أو غيرها أن يحمل على
نفي الكفاية ومنع الاعتداد بها
وأيضا هو أن النبي عليه السلام لا يقصد بهذه الألفاظ النفي من طريق اللغة
والمشاهدة وإنما يقصد ببيان الشرع لأنه بعث مبينا للشرع فيجب أن يحمل على
نفي كل ما يحمله الشرع من كامل أو جائز كما إذا قال لا رجل في الدار لما
كان القصد نفي ما يسمى رجلا في اللغة حمل على كل ما يحتمله الرجل من طويل
أو قصير فكذلك هاهنا
ولأن قوله لا صلاة نفي لنفس الصلاة في الشرع فمتى صححنا الصلاة فقد أثبتنا
ما نفاه وذلك خلاف الظاهر
واحتجوا بأن النفي في هذه الألفاظ لا يجوز أن يكون راجعا إلى المذكور من
النكاح والعمل فإن ذلك كله موجود فوجب أن يكون راجعا إلى غيره وذلك الغير
يحتمل الجواز والفضيلة وليس أحدهما بأولى من الآخر والحمل عليهما لا يجوز
لأنه دعوى عموم في المضمر والعموم من أحكام اللفظ وصفاته
ولأن الحمل عليهما لا يجوز لأنه يؤدي إلى التناقض لأن حمله على نفي
الفضيلة والكمال يقتضي صحة الفعل وجوازه وحمله على نفي الجواز يمنع صحة
الفعل
ولأن الفضيلة والجواز معنيان مختلفان فلا يجوز حمل اللفظ الواحد
على معنيين مختلفين فوجب التوقف فيه حتى يرد البيان
والجواب أن من أصحابنا من قال النفي راجع إلى نفس المذكور وهو النكاح
الشرعي والعمل الشرعي ونحن ننفي ذلك على سبيل الحقيقة فنقول إن النكاح
الشرعي ما وجد والعمل الشرعي ما وجد ومتى سلكنا هذا الطريق استغنينا عن
ادعاء العموم في المضمر وحمل الكلام على التناقض وعلى معنيين مختلفين
ومن أصحابنا من قال إن النفي يرجع إلى أحكام المذكور وصفاته وهي وإن لم
تكن مذكورة إلا أنها معقولة منه من ظواهر اللفظ
ألا ترى أنه إذا قال الرجل لغيره رفعت عنك جنايتك عقل من ذلك أحكام
الجناية وما يتعلق بها وما كان معقولا من اللفظ كان بمنزلة المنطوق به
ألا ترى أن فحوى الخطاب لما كان معقولا من ظاهر اللفظ حمل الكلام عليه وإن
لم يكن مذكورا
وقولهم إن الحمل على الجميع دعوى عموم في المضمر وذلك لا يجوز غير مسلم
لأن المضمر كالمظهر ويجوز دعوى العموم فيه كما يجوز في المظهر
وقوله إن الحمل عليها يؤدي إلى التناقض غلط لأنه لو كان متناقضا لما صح
الجمع بينهما بصريح النطق كما لا يجوز في سائر المعاني المتناقضة ولما صح
أن يقول لا نكاح كامل ولا جائز إلا بولي دل على أنه غير متناقض
وقولهم إنهما معنيان مختلفان فلا يحمل اللفظ عليهما لا يسلم أيضا فإن
عندنا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وقد بينا ذلك فيما تقدم
فأغنى عن الإعادة
قالوا أحكام العين غير معقولة عند العرب ومالا يعقل في اللغة من
ظاهر اللفظ لم يجز حمل الكلام عليه من غير دليل كسائر المجملات
قلنا لا نسلم أن الأحكام لا تعقل بل ذلك معقول عندهم
ألا ترى أنه إذا قال لعبده رفعت عنك جريرتك وأسقطت عنك جنايتك عقل من ذلك
أحكام الفعل فبطل ما قالوه
مسألة 11
يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في قول المزني وأبي العباس وعامة أصحابناوقال بعضهم لا يجوز ذلك وهو قول المعتزلة
وقال بعض شيوخنا يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم
وقال بعضهم يجوز تأخير بيان العموم ولا يجوز تأخير بيان المجمل
ومن الناس من قال يجوز ذلك في الأخبار دون الأمر والنهي
ومنهم من عكس ذلك فأجاز في الأمر والنهي دون الأخبار
لنا قوله تعالى آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وقوله فإذا قرآناه فاتبع
قرآنه ثم إن علينا بيانه وثم تقتضي المهلة والتراخي فدل على أن التفصيل
والبيان يجوز أن يتأخر عن الخطاب
وأيضا هو أن الله تعالى أوجب الصلوات الخمس ولم يبين أوقاتها ولا أفعالها
حتى نزل جبريل عليه السلام فبين للنبي صلى الله عليه و سلم كل صلاة في
وقتها وبين النبي صلى الله عليه و سلم أفعالها للناس في أوقاتها وقال صلوا
كما رأيتموني أصلي وكذلك أمر بالحج وأخر النبي صلى الله عليه و سلم بيانه
إلى أن حج ثم قال خذوا عني مناسككم ولو لم يجز التأخير لما أخر عن وقت
الخطاب
ويدل عليه هو أن البيان إنما يحتاج إليه الفعل المأمور به كما يحتاج إلى
القدرة لفعل المأمور به ثم يجوز تأخير الاقتدار عن وقت الخطاب
إلى وقت الحاجة فكذلك تأخير البيان
وأيضا هو أن النسخ تخصيص الأزمان كما أن التخصيص تخصيص الأعيان ثم تأخير
بيان النسخ يجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وكذلك تأخير بيان التخصيص
فإن قيل لا نسلم النسخ فإنه لا يجوز تأخير بيانه حتى يشعر عند الخطاب
بنسخه
قيل إن أردتم بذلك أنه لا يجوز حتى يشعر بوقت النسخ فهذا لا يقوله أحد
ومتى قرن بالخطاب بيان الوقت لم يعد ذلك نسخا ولهذا لم يقل أحد إن قوله
تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل يصير منسوخا بدخول الليل
وإن أردتم به أنه لا بد من أن يشعر بالنسخ في الجملة فخطأ لأن الله تعالى
أمر بأشياء ثم نسخها كالتوجه إلى بيت المقدس وغيرها ولم يقرن بشيء منها
الأشعار بأنه ينسخه فيما بعد فدل على أن ذلك لا يجب
وعلى أن وقت النسخ لا يجب بيانه عند الخطاب فيجب أن يكون المخصوص من
العموم لا يجب بيانه عند الخطاب
فإن قيل تأخير بيان النسخ لا يخل بصحة الأداء فيما مضى من الزمان وتأخير
بيان التخصيص يخل بصحة الأداء
قلنا لا يخل بصحة الأداء لأنه بينه عند الحاجة إلى الفعل فيتأدى الفعل على
حسب المراد
واحتجوا بأن المراد يخص مرة بالاستثناء ومرة بالدليل ثم التخصيص
بالاستثناء لا يجوز أن يتأخر عن العموم وكذلك التخصيص بالدليل
قلنا الاستثناء لا يستقل بنفسه ولا يفيد معنى فلم يجز تأخيره
والتخصيص بالدليل يستقل بنفسه مفيدا فجاز تأخيره
ويدلك عليه أن الاستثناء لو تقدم على الخطاب لم يجز ولو تقدم الدليل
الموجب للتخصيص جاز فافترقا
قالوا ولأن البيان مع المبين بمنزلة الجملة الواحدة ألا ترى أنهما
لمجموعهما يدلان على المقصود فهما كالمبتدأ والخبر ولا خلاف أنه لا يحسن
تأخير الخبر عن المبتدأ بأن يقول زيد ثم يقول بعد حين قائم فكذلك تأخير
البيان
قلنا فيما ذكرتم إنما لم يصح لأن التفريق بينهما ليس من أقسام الخطاب
وأنواع كلامهم وليس كذلك إطلاق العموم والمجمل فإنه من أقسام خطابهم
وأنواع جوابهم لأنهم يتكملون بالعموم والمجمل وإن افتقر إلى البيان
فافترقا
قالوا ولأنه إذا ورد اللفظ العام وتأخر بيانه اعتقد السامع عمومه وذلك
اعتقاد جهل فيجب أن لا يجوز
قلنا يبطل به إذا أخر بيان النسخ فإن السامع يعتقد عمومه وهو اعتقاد جهل
وقد جوزناه على أن عندنا يعتقد عمومه بشرط أن لا يكون هناك ما يخصه وإذا
ورد التخصيص علمنا أن المخصوص لم يدخل في العموم
قالوا ولأنه إذا خوطب بلفظ والمراد به غير ظاهره فقد خاطب بغير ما يقتضيه
اللفظ وذلك لا يجوز كما لو قال اقتلوا المسلمين والمراد به المشركين أو
قال قوموا والمراد اقعدوا
قلنا هذا يبطل بتأخير بيان النسخ فإنه خاطب بغير ما يقتضيه اللفظ لأن
اللفظ يقتضي التأبيد ثم يجوز
وأما إذا قال اقتلوا المسلمين والمراد به المشركين وقوموا
والمراد به اقعدوا فإنما لم يجز لأن أحد هذين اللفظين لا يستعمل في موضع
الآخر بوجه من وجوه الاستعمال لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز
والخطاب بأحدهما في موضع الآخر خارج عن أقسام كلامهم وليس كذلك العام
المخصوص والمجمل المفتقر إلى البيان فإنه معتاد في كلامهم جار في خطابهم
فافترقا
قالوا ولأنه إذا أخر البيان لم يدل الكلام على المقصود ولا يجوز أن يخاطب
بشيء ولا يدل على المقصود به كما لو خاطب العربي بالعجمية والفارسي
بالتركية
قلنا هذا يبطل به إذا أطلق الخطاب ولم يبين وقت النسخ فإنه لم يدل على
المقصود ومع ذلك فإنه يجوز
وأما خطاب العربي بالعجمية والفارسي بالتركية فهو حجة عليهم لأن الله
تعالى خاطب العجم بالعربية وإن لم يدلهم على المقصود حال الخطاب فيجب أن
يجوز بالعام والمجمل وإن لم يدل فيهما على المقصود
قالوا ولأن المجمل إذا تأخر بيانه لم يفد شيئا فصار كالخطاب بلفظ مهمل
قلنا لا نسلم أنه لا يفيد شيئا بل يفيد فائدة صحيحة
ألا ترى أن العربي إذا سمع قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده عقل من ذلك
تعلق حق بالزرع في يوم الحصاد وإن لم يعرف جنسه وقدره ويخالف اللفظ المهمل
فإنه لا يفيد معنى أصلا فلم يجز الخطاب به
قالوا لو جاز تأخير البيان لجاز للرسول عليه السلام تأخير البلاغ عن الله
تعالى وقد أمره الله بالتبليغ فقال بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل
فما بلغت رسالته
والجواب أن عندنا تأخير البلاغ جائز والأمر الوارد في ذلك لا يقتضي الفور
بإطلاقه
مسائل المطلق والمقيد
مسألة 1
لا يحمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين كآية الظهار والقتل من غير دليلومن أصحابنا من قال يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظ
لنا هو أن اللفظ المقيد لا يتناول المطلق فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة
ألا ترى أن البر لما لم يتناول الأرز لم يجز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة فكذلك هاهنا
ولأن اللفظ المطلق لا يتناول المقيد فلو جاز أن يجعل المطلق مقيدا لتقييد
غيره لجاز أن يجعل القيد مطلقا لإطلاق غيره ولما لم يجز أحدهما
لم يجز الآخر
وأيضا هو أنه لو جاز أن يجعل ما أطلق مقيدا لتقييد غيره لجاز أن يجعل
العام خاصا لتخصيص غيره ولوجب أن يجعل المطلق مشروطا لدخول الشرط في غيره
وهذا يمنع التقييد بالكلام ويبطل الفرق بين العام والخاص وهذا لا يجوز
واحتجوا بأن حمل المطلق على المقيد من جهة اللفظ لغة العرب
ألا ترى أن الله تعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من
الأموال والأنفس والثمرات وأراد نقص من الأنفس ونقص من الثمرات ولكنه لما
قيده بالأنفس اكتفى به في الباقي وقال الله تعالى والذاكرون الله كثيرا
والذاكرات فقيافي أحد الجنسين واكتفى به في الجنس الآخر وقال الشاعر ...
وما أدري إذا يممت أرضا ... أريد الخير أيهما يليني ... هو الخير الذي أنا
أبتغيه ... أم الشر الذي هو يبتغيني ...
فاكتفى بأحدهما عن الآخر وقال الآخر
أنا الرجل الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو
مثلي ...
فاكتفى بأحدهما عن الآخر
والجواب أن فيما ذكروه إنما يحمل المطلق على المقيد لأنه لو لم يحمل
الثاني على الأول لالتبس الكلام ولم يفد فحمل أحدهما على الآخر لموضع
الضرورة وليس هاهنا ضرورة تقتضي الحمل ولفظ أحدهما لا يتناول الآخر فحمل
كل واحد منهما على ظاهره
واحتجوا بأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة فوجب ضم بعضه
إلى بعض
قلنا هذا دعوى فكيف يكون كذلك وهو يشتمل على معان مختلفة وأصناف شتى من
القصص والأمثال والأحكام وغير ذلك
ثم لو كان هذا يوجب حمل بعضه على بعض لوجب أن يخص كل عام فيه لأن فيه ما
هو مخصوص ويجعل كل أمر فيه ندبا لأن فيه ما هو مندوب وللزم أن يجعل ما
قيده فيه مطلقا ولم يكن حمل المطلق على المقيد بأولى من حمل المقيد على
المطلق ولما بطل هذا بطل ما قالوه
مسألة 2
يجوز حمل المطلق في أحد الحكمين على المقيد في الحكم الآخر من جهة القياس كالرقبة المطلقة في كفارة الظهار على الرقبة
المقيدة في كفارة القتل بالإيمان
وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز
لنا هو أن هذا تخصيص عموم لأن قوله تعالى فتحرير رقبة عام في الرقبة
المؤمنة والكافرة فإذا قلنا إن الكافرة لا تجوز خصصنا الكافرة من العموم
بالقياس وتخصيص العموم بالقياس جائز كسائر العمومات
واحتجوا بأن هذه زيادة في النص والزيادة في النص نسخ عندنا والنسخ بالقياس
لا يجوز
والجواب أن هذا ليس بزيادة وإنما هو نقصان بالحقيقة لأن اللفظ المطلق
يقتضي جواز كل رقبة مؤمنة كانت أو كافرة فإذا منعنا الكافرة فقد أخرجنا
بعض ما يقتضيه الظاهر وذلك نقصان وتخصيص فأما أن يكون زيادة فلا
فإن قيل التخصيص هو أن يخرج من اللفظ بعض ما تناوله وقوله تعالى فتحرير
رقبة لا يتناول الإيمان فمن اعتبر ذلك فقد زاد شرطا لا يقتضيه اللفظ فدل
على أنه زيادة
قلنا اللفظ وإن لم يتناول الإيمان فقد تناول الكافرة فإذا قلنا إن الكافرة
لا تجزي فقد أخرجنا من اللفظ بعض ما تناوله بعمومه فكان ذلك تخصيصا
وعلى أن الزيادة عندنا ليست بنسخ فلا يصح ما بنوا عليه من الدليل
قالوا ولأن الرقبة في الظهار منصوص عليها وفي القتل منصوص عليها
وقياس المنصوص على المنصوص لا يجوز ولهذا لم يجز قياس صوم التمتع على صوم
الظهار في إيجاب التتابع ولا صوم الظهار على صوم التمتع في إيجاب التفريق
ولهذا لم يجز قياس حد السرقة على حد قاطع الطريق في إيجاب قطع الرجل
ولهذا لم يجز قياس التيمم على الوضوء في إيجاب مسح الرأس والرجل
والجواب أن في صوم التمتع وصوم الظهار نص على حكمين متضادين فحمل أحدهما
على الآخر إبطال للنص وليس كذلك هاهنا فإن اللفظ في الظهار مطلق وفي القتل
مقيد وفي أحدهما عام مطلق وفي الآخر خاص مبين فيحمل أحدهما على الآخر
وأما حد السرقة فإنما لم يحمل على قطاع الطريق ولا آية التيمم على آية
الوضوء في مسح الرأس والرجل لأن الإجماع منع منه ومن شرط القياس أن لا
يعارضه إجماع وهاهنا لم يعارضه إجماع ولا غيره فجاز قياس أحدهما على الآخر
كقياس التيمم على الوضوء في إيجاب المرفقين لما لم يعارضه إجماع ولا غيره
أجزناه
مسائل دليل الخطاب
مسألة 1
إذا علق الحكم في الشيء على صفة من صفاته دل على أن ما عداها يخالفهوقال أبو العباس بن سريج وأبو بكر القفال والقاضي أبو حامد رحمهم الله وقوم من المتكلمين لا يدل على المخالفة وهو قول أصحاب أبي حنيفة
وحكي عن بعضهم أنه فرق بين المعلق على غاية والمعلق على غير
غاية
وحكي عن بعضهم أنه فرق بين أن يكون بلفظ الشرط وبين أن لا يكون بلفظ الشرط
لنا ما روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما بالنا
نقصر وقد أمنا وقد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقال عمر عجبت مما عجبت
منه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم
فاقبلوا صدقته وهذا دليل على أن تعليق القصر بالخوف اقتضى أن حال الأمن لا
يجوز حتى عجب منه عمر ويعلى وأقرهم النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك
وروي أن ابن عباس خالف الصحابة في توريث الأخت مع البنت واحتج بقوله تعالى
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهذا تعلق بدليل الخطاب
وأنه لما ثبت ميراث الأخت عند عدم الولد دل على أن عند وجوده لا تستحقه
وهو من فصحاء الصحابة وعلمائهم ولم ينكر أحد استدلاله فدل على أن ذلك
مقتضى اللغة
وأيضا هو من الأنصار قالوا لا غسل من التقاء الختانين واحتجوا
بقوله عليه السلام الماء من الماء وهذا استدلال بدليل الخطاب
ومن قال منهم أنه يجب الغسل أجاب بأن الماء من الماء منسوخ وهذا اتفاق
منهم على دليل الخطاب
فإن قيل لا نسلم أنهم رجعوا في هذه المواضع إلى دليل الخطاب وإنما رجعوا
إلى الأصل وذلك أنهم أثبتوا القصر والميراث والغسل في المواضع التي
تناولها الخطاب بالنطق ورجعوا فيما لا خطاب فيه إلى الأصل وهو أنه لا قصر
ولا ميراث ولا غسل
قلنا لم يرجعوا في هذه المواضع إلا إلى موجب النطق ودليل الخطاب
ألا ترى أن يعلى بن أمية قال لعمر ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال الله
تعلى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فتعلق بموجب النطق ولم يقل والأصل هو
الإتمام
وقالت الصحابة رضي الله عنهم قوله الماء من الماء كان رخصة وقد نسخ
وأرادوا دليل الخطاب ولو رجعوا في ذلك إلى الأصل لما وصفوه بالنسخ لأن
النسخ رفع ما ثبت بالشرع فأما ما كانوا عليه في الأصل ونقل إلى غيره فلا
يقال إنه منسوخ فدل على أن المحتج منهم إنما احتج بدليل الخطاب
وأيضا هو أن ضم الصفة إلى الاسم يقتضي المخالفة والتمييز في كلام العرب
ألا ترى أنهم لا يقولون أعط زيدا الطويل وعمرا القصير والطويل والقصير
عندهم واحد فدل على أن موضوع اللفظ المخالفة والتمييز
ولأن تقييد الاسم العام بالصفة يقتضي التخصيص ألا تراه لو لم
يقيد الغنم بالسوم اقتضى السائمة والمعلوفة فإذا قيدها بالسوم منع هذا
التقييد دخول المعلوفة واقتضى اختصاص الزكاة بالسائمة وكل ما اقتضى تخصيص
الاسم العام وجب أن يقتضي المخالفة والدليل عليه سائر الألفاظ التي يخص
بها العموم
ولأنه قيد الحكم بما لو انتزع منه لعم فوجب أن يتضمن النفي والإثبات
كالاستثناء والغاية
وأيضا فإنه إذا قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا
إحداهن بالتراب أفاد تعليق الطهارة بالسبع فمتى طهرناه بما دون السبع خرج
السبع عن أن يكون مطهرا لأن الغسلة السابعة ترد والمحل محكوم بطهارته
وهكذا إذا قال في سائمة الغنم زكاة
أفاد تعلق الوجوب بالسائمة فمتى أوجبنا الزكاة في المعلوفة أخرجنا السائمة
عن أن يتعلق بها الوجوب
واحتجوا بأن إثبات الحكم بدليل الخطاب إما أن يكون بالعقل ولا مجال له فيه
أو بالنقل ولا يخلو إما أن يكون ذلك تواترا أو آحادا ولا يجوز أن يكون
تواترا لأنه لو كان فيه تواتر لعلمناه كما علمتم ولا يجوز أن يكون آحادا
لأنه من مسائل الأصول ولا يكفي في إثباتها خبر الواحد
قلنا قد أثبتناها بالنقل وهو ما رويناه عن الصحابة رضي الله عنهم
فإن قيل إلا أنه من طريق الآحاد فلا تثبت به مسائل الأصول
قيل هو وإن كان من أخبار الآحاد إلا أنه يجري مجرى التواتر لأن الأمة
تلقته بالقبول فاتفقت على صحته وإن اختلفت في العمل به
قالوا وأيضا هو أن الصفات وضعت للتمييز بين الأنواع كما وضعت الأسماء
للتمييز بين الأجناس ثم تعليق الحكم على الاسم لا يقتضي نفيه عما عداه
فكذلك تعليقه على الصفة
والجواب أن من أصحابنا من قال أن تعليق الحكم على الاسم يقتضي نفيه عما
عداه وهو قول أبي بكر الدقاق فعلى هذا لا نسلم
وإن سلمنا ذلك على ظاهر المذهب فالفرق بينهما من وجوه
أحدها هو أن العرب قد تجمع بين الأجناس المختلفة في الحكم وتنص على اسم كل
واحد منها ألا تراها تقول اشتر لحما وتمرا وخبزا ولا تقيد الحكم بالصفة
والموصوف بتلك الصفة وضدها واحد ألا تراها لا تقول اشتر لحما مشويا
والمشوي والنيء عندها سواء ولا اشتر تمرا برنيا والبرني وغيره عندهم سواء
والثاني أن تعليق الحكم على بعض الأسماء لا يمنع تعليقه بغيرها من الأسماء
ألا ترى أنه إذا أجب الزكاة في الغنم ثم أوجبها في البقر لم يمنع تعلقها
بالبقر من تعلقها بالغنم وتعليق الحكم على أحد صفتي الشيء يمنع تعلقه
بضدها ألا ترى أنه إذا علق الزكاة على سائمة الغنم ثم أوجبها في المعلوفة
خرج عن أن يكون الوجوب متعلقا بالسائمة وبقيت الزكاة معلقة على الاسم فقط
والثالث هو أن تعليق الحكم بالاسم لا يقتضي تخصيص اسم عام فلم
يقتض المخالفة وتعليقه بالصفة يقتضي تخصيص اسم عام والتخصيص لا يكون إلا
بما يقتضي المخالفة كالاستثناء والغاية
ولأن الاسم لا يجوز أن يكون علة في الحكم فتعليق الحكم عليه لا يقتضي
المخالفة والصفة يجوز أن تكون علة في الحكم فتعليق الحكم عليه يقتضي
المخالفة
قالوا لو كان إيجاب الزكاة في السائمة يوجب نفي الزكاة عن المعلوفة لكان
التسوية بينهما في إيجاب الزكاة مناقضة ولما جاز أن يقول في سائمة الغنم
زكاة وفي معلوفتها الزكاة دل على أن الإيجاب في أحد النوعين لا يقتضي
النفي عن النوع الآخر
قلنا يبطل بالغاية فإنها تقتضي المخالفة على قول كثير منهم وإن جاز أن
يصرح فيما بعدها بحكم ما قبلها وعلى أن اللفظ يجوز أن يدل بظاهره على معنى
ثم يترك ظاهره بما هو أقوى منه كالأمر يدل ظاهره على الإيجاب ثم يدل
الدليل على أن المراد به الاستحباب فيترك ظاهره ولا يدل على أن في الأصل
لا يقتضي الوجوب فكذلك هاهنا اللفظ بظاهره يدل على النفي والإثبات ثم إذا
صرح في الوجهين بالتسوية ترك الظاهر وحمل على ما اقتضاه التصريح
قالوا ولأنه ليس في كلام العرب كلمة تدل على شيئين متضادين وعندكم أن هذا
اللفظ يدل على إثبات الحكم ونفيه وهذا خلاف اللغة
قلنا هذا يبطل بلفظ الغاية وأنه قد دل على إثبات الحكم فيما قبل الغاية
ونفيه عما بعدها وهما متضادان فكذلك الأمر بالشيء يدل على وجوب المأمور
والانتهاء عن ضده وهما متضادان
قالوا ولأن دليل الخطاب مفهوم الخطاب ومفهوم الخطاب ما وافقه كالتنبيه
والقياس ودليل الخطاب ضد الخطاب فلا يجوز أن يكون مفهوما منه
قلنا هذا يبطل بالأمر بالشيء فإنه يفهم منه النهي عن ضده وإن
كان ضد اللفظ
وأما القياس والتنبيه فإنهما وافقا الخطاب لأنهما مفهومان من معناه
والدليل مفهوم من جهة التخصيص فكان مخالفا له كحكم ما بعد الغاية
قالوا ولأنه لو كان للنطق دليل لكان معه بمنزلة الخطابين ولو كان كذلك لما
جاز تركه بالقياس كما لا يجوز ترك الخطاب ولوجب إذا نسخ الخطاب أن يبقى
الدليل كما إذا نسخ أحد الخطابين بقي الخطاب الآخر
قلنا لا نقول إن الدليل مع الخطاب بمنزلة الخطابين بل هو بعض مقتضاه وإذا
كان ذلك بعض مقتضاه جاز تركه بالقياس كما يجوز ترك بعض ما اقتضاه العموم
بالقياس
وأما إذا نسخ الخطاب فمن أصحابنا من قال يبقى حكم الدليل والصحيح أنه يسقط
الدليل لأن الدليل مقتضى الخطاب ومفهومه فإذا بطل الخطاب بطل المفهوم كما
تقول الأمر بالشيء لما كان النهي عن ضده مقتضاه ومفهومه فمتى سقط الأمر
سقط النهي كذلك هاهنا ويخالف النطقين إذا نسخ أحدهما لأن أحدهما غير متعلق
بالآخر فنسخ أحدهما لا يوجب نسخ الآخر وهاهنا الدليل تابع للنطق ومستفاد
منه فإذا سقط الأصل سقط تابعه كما قلنا في النهي المستفاد من الأمر
قالوا لو كان دليل الخطاب يقتضي الحكم لكان ذلك مستنبطا من اللفظ وما
استنبط من اللفظ لا يجوز تخصيصه كالعلة
قلنا لا نقول أن الدليل مستنبط من اللفظ بل اللفظ يدل عليه بنفسه في
اللغة وما يدل عليه اللفظ في اللغة جاز تخصيصه كسائر الألفاظ
قالوا لو كان تعليق الحكم على صفة الشيء يدل على نفيه عما عداها لوجب أن
لا يحسن فيه الاستفهام كما لا يحسن في نفس النطق
قلنا إنما حسن فيه الاستفهام لأنه يجوز أن يكون قد علق الحكم على أحد
صفتيه ليدل على المخالفة ويجوز أن يكون قد خص أحد وصفيه بالحكم للشرف
والفضيلة فحسن الاستفهام ليزول هذا الاحتمال ويخالف هذا النطق لأنه لا
احتمال فيه فلم يحسن فيه الاستفهام
مسألة 2
إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس ولا يدل على النفي عما عداها في سائر الأجناسومن أصحابنا من قال يدل على نفيه عما عداها في الأجناس كلها
لنا هو أن الدليل يقتضي النطق فإذا تناول النطق في سائمة الغنم وجب أن يكون دليله يتناول معلوفة الغنم فقط
واحتجوا بأن السوم يجري مجرى العلة في تعليق الحكم عليها والعلة حيث وجدت تعلق الحكم بها فكذلك هذا
قلنا لا نسلم أن السوم بمنزلة العلة ألا ترى أنه علق الحكم على مجموعها ومتى تعلق الحكم بوصفين كان كل واحد منهما بعض العلة فلا يجوز تعلق الحكم على أحدهما على الانفراد
مسألة 3
قوله تعالى ولا تقل لهما أف يدل على المنع من الضرب من ناحية المعنىوكذلك قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة يدل على ما زاد عليه من ناحية المعنى
وقال بعض أصحابنا يدل على ذلك من ناحية اللغة وهو قول عامة المتكملين وبعض أهل الظاهر
لنا هو أن التأفيف في اللغة غير موضوع للضرب والذرة غير موضوعة لما زاد عليها فوجب أن يكون المنع مما زاد مفهوما من طريق المعنى
واحتجوا بأن أهل اللسان يفهمون من هذا الكلام المنع مما زاد عليه ولهذا
إذا قال لعبده إياك أن تقول لفلان عقل منه المنع عما زاد عليه
والجواب أنا لا نسلم أنهم يفهمون ذلك من اللفظ وكيف يفهم ذلك من اللفظ
واللفظ غير موضوع له وإنما يفهم ذلك من طريق المعنى لكن المعنى إذا كان
جليا اشترك الخاص والعام في إدراكه
وحكى أن ابن داود قال لأبي العباس بن سريج أن ذرتين فصاعدا ذرة وذرة فكل
ذرة منهما داخلة تحت الاسم فيكون اللفظ دالا على ما زاد فألزمه أبو العباس
نصف ذرة وقال لا يسمى نصف ذرة ذرة على أن المعنى دل عليه
مسألة 4
الاستدلال بالقران لا يجوزومن أصحابنا من قال يجوز وهو قول المزنى
لنا هو أن كل واحد من اللفظين المقترنين يقتضي غير ما يقتضيه الآخر فلا يحمل أحدهما على ما يحمل عليه الآخر من جهة اللفظ كما لو وردا غير مقترنين ويدل عليه هو أنه إذا جمعت بين شيئين علة في حكم لم يجب أن يستويا في جميع الأحكام فكذلك إذا جمعهما لفظ صاحب الشرع لم يجب أن يستويا في جميع الأحكام
واحتجوا بقوله صلى الله عليه و سلم لا يفرق بين مجتمعين ولم يفرق
والجواب هو أن هذا وارد في باب الزكاة وأن النصاب المجتمع في ملك رجلين لا يفرق بينهما
واحتجوا بما روي عن أبي الصديق رضي الله عنه أنه قال في قتال
مانعي الزكاة لا أفرق بين ما جمع الله قال الله تعالى وأقيموا
الصلاة وآتوا الزكاة
وبما روي عن ابن عباس في العمرة إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى قال
الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله
والجواب هو أن أبا أنا بكر رضي الله عنه أراد لا أفرق بين ما جمع الله في
الإيجاب بالأمر وكذلك ابن عباس إنها لقرينة الحج في الأمر والأمر يقتضي
الوجوب فكان الاحتجاج في الحقيقة بظاهر الأمر لا بالاقتران
مسألة 5
الواو تقتضي الترتيب في قول بعض أصحابنا وهو مذهب ثعلب وأبي عمر الزاهد غلام ثعلب ومن أصحابنا من قال لا تقتضي الترتيب وهو قول أصحاب أبي حنيفة
لنا ما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يقول من يطع الله
ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال له عليه السلام بئس الخطيب أنت قل
ومن يعص الله ورسوله فلو كانت الواو تفيد الجمع دون الترتيب لكان قد نهاه
عن شيء وأمره بمثله وذلك لا يجوز
وأيضا ما روي أن عبد بني الحسحاس أنشد عمر رضي الله عنه قوله ... عميرة
ودع إن تجهزت غاديا ... كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا
فقال عمر رضي الله عنه لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك فدل
على أن الواو اقتضت الترتيب
وأيضا ما روي أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنه كيف تقدم العمرة على
الحج وقد قدم الله الحج على العمرة فقال ابن عباس كما تقدم الدين على
الوصية فدل على أنهم فهموا من التقديم في اللفظ التقديم في الحكم
وأيضا هو أن رجلا لو كتب كتابا في معنى رجلين وقال أنفذت إليك فلانا
وفلانا سبق إلى فهم كل أحد من أهل اللغة أن المقدم في الذكر هو المقدم في
الرتبة فدل على أن الواو اقتضت الترتيب
ولأن المعنى نتيجة اللفظ واللفظ في أحدهما سابق فكان المعنى سابقا
ولأنه لو قال لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق وطالق وقعت الأولى دون
الثانية فلو كانت الواو للجمع دون الترتيب لوقعت الطلقتان كما لو قال أنت
طالق تطليقتين ولما وقعت الأولى دون الثانية دل على أن الأولى سبقت في
الوقوع ثم جاءت الثانية فصادفتها وهي بائن فلم تقع
واحتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يقول ما
شاء الله وشئت فقال أمثلان أنتما قل ما شاء الله ثم شئت ولو كانت الواو
تقتضي الترتيب لما نقله عن الواو إلى ثم لأنهما في الترتيب سواء
والجواب هو إنما نقله عن الواو إلى ثم لأن الواو وإن اقتضت الترتيب فإنها
لا تقتضي المهلة وثم تقتضي المهلة فنقله عما لا يقتضي المهلة إلى ما يقتضي
المهلة في الاسمين المتفقين
قالوا ولأن الواو تدخل في الاسمين المختلفين بدلا من التثنية في الاسمين
المتفقين فإذا كان لفظ في الاسمين المتفقين لا يقتضي الترتيب وجب أن تكون
الواو في الاسمين المختلفين لا تقتضي الترتيب
والجواب أن هذه دعوى لا دليل عليها ثم هو باطل بتكرير الطلاق على من لم
يدخل بها
قالوا ولأنه لو كانت الواو تقتضي الترتيب لجاز أن تجعل في جواب الشرط
كالفاء ولما لم يجز أن تجعل جوابا للشرط دل على أنها لا تقتضي الترتيب
قلنا يبطل بثم فإنها لا تستعمل في جواب الشرط ثم تقتضي الترتيب
فإن قيل إنما لم يجعل ثم جوابا للشرط لأنها تقتضي المهلة ومن حكم
الجواب أن لا يتأخر عن الشرط والواو لا تقتضي ذلك ولو اقتضت
الترتيب لجاز أن تجعل جوابا للشرط
قيل إن كانت ثم تقتضي المهلة فلم تجعل جوابا للشرط حتى لا يتأخر الجزاء عن
الشرط فكذلك الواو ولم تجعل جوابا للشرط لأنها تحتمل التراخي ومن حكم
الجزاء أن لا يتأخر عن الشرط فلم يجز أن تجعل جوابا للشرط لذلك
قالوا ولأنا رأينا الواو تستعمل في مواضع تحتمل الترتيب كقوله تعالى
ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا فلو رتبت
الواو لم يجز أن يقدم في أحد الموضعين ما أخره في الموضع الآخر وكقول
الشاعر ... ومنهل فيه الغراب ميت ... كأنه من الأجون زيت ... سقيت منه
القوم واستقيت ...
ومعلوم أنه استقى أولا ثم سقى فدل على أنه لا يقتضي الترتيب
قلنا ليس إذا استعملت في مواضع لا تحتمل الترتيب دل على أنها غير موضوعة
للترتيب ألا ترى أن ثم استعملت في مواضع لا تحتمل الترتيب كقوله تعالى
فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون والمراد به والله شهيد
وقول الشاعر
كهز الرديني تحت العجاج ... جرى في الأنابيب ثم اضطرب ...
ومعلوم أن الاهتزاز والاضطراب لا يفترقان ولا يدل على أن ثم غير موضوعة
للترتيب والتفريق
وعلى أن البيت الذي ذكره لا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون ذلك إخبارا عن
أفعال متفرقة لا يتعلق بعضها ببعض فتكون على الترتيب
قالوا لو كانت الواو ترتب لما حسن استعمال لفظ المقارنة فيه بأن تقول جاء
زيد وعمرو معا كما لا يجوز جاء زيد ثم عمر معا
قلنا يجوز أن يكون اللفظ يقتضي معنى ثم يتغير ذلك بما يدخل عليه من الحروف
والألفاظ
ألا ترى أن قوله زيد في الدار يقتضي الإخبار ثم تدخل عليه الألف فنقول
أزيد في الدار فيصير استفهاما فكذلك هاهنا
مسألة 6
الباء إذا دخلت على فعل يتعدى من غير باء اقتضت التبعيض في قول بعض أصحابنا وذلك مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكموقال أصحاب أبي حنيفة لا تقتضي التبعيض
لنا أن أهل اللسان فرقوا بين قولهم أخذت قميص فلان وبين قولهم أخذت بقميص فلان فيحملون الأول على أخذ جميعه والثاني على التعلق ببعضه
ويدل عليه هو أنه إذا قال مسحت يدي بالمنديل ومسحت يدي بالحائط عقل من ذلك كله التبعيض فدل على أن ذلك مقتضاه
واحتجوا بأن الباء موضوعة لإلصاق الفعل بالمفعول يدلك عليه أنك
تقول مررت بزيد وكتبت بالقلم وطفت بالبيت فتفيد الباء إلحاق الفعل
بالمفعول
والجواب عن ذلك كله هو أن في المرور والكتابة إنما حملا على الإلصاق لأن
الفعل لا يتعدى بغير الباء ألا ترى أنه لو قال مررت زيدا وكتبت القلم لم
يكن ذلك كلاما صحيحا فكان دخولها للإلصاق وهاهنا الفعل يتعدى إلى المفعول
ويلحق به من غير الباء فكان دخولها للتبعيض
وأما قولهم طفت بالبيت فإنا لا نحمله على التبعيض لأن الطواف عبارة عن
الجولان حول جميع البيت ألا ترى أنه إذا فاتته طائفة من البيت لم يسم
طائفا فروعي مقتضى اللفظ فجعلت الباء مزيدة في الكلام وليس كذلك قوله مسحت
بالرأس لأن الفعل يستعمل في البعض والكل فإذا دخلت الباء وجب أن يحمل على
البعض كما قلنا في قوله أخذت بقميصه
مسألة 7
إنما تدخل في الكلام لإثبات الحكم في المذكور وحده ونفيه عما عداه وبه قال القاضي أبو حامد مع نفيه لدليل الخطابوقال كثير من المتكلمين لا يقتضي نفي الحكم عما عداه
لنا هو أن هذا اللفظ لا يستعمل في عرف أهل اللسان إلا فيما ذكرناه يدلك عليه هو أن رجلا لو قال لغيره هل في الدار غير زيد فقال له إنما في الدار زيد كان ذلك بمنزلة قوله ليس في الدار غير زيد ولو لم يقتض إثبات الحكم في المذكور والنفي عما عداه لما صار بذلك مجيبا ويدلك عليه قوله تعالى إنما الله إله واحد والمراد به لا إله إلا واحد وقول الشاعر ... أنا الرجل الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي ...
والمراد به ما ذكرناه
واحتجوا بأن هذه الكلمة تدخل في الكلام لتأكيد المذكور أما في نفي أو إثبات وقد بينا أن النفي لا يدل على الإثبات والإثبات لا يدل على النفي
والجواب أنا قد بينا أنه يدخل لإثبات الحكم المذكور بعده ونفي ما عداه فسقط ما قالوه
مسائل الأفعال
مسألة 1
ما فعله النبي صلى الله عليه و سلم وعلم أنه فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة شاركته الأمة فيهوكذلك ما أمر به شاركته الأمة فيه ما لم يدل الدليل على تخصيصه
وقالت الأشعرية لا تشاركه فيه الأمة إلا بدليل
لنا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقوله تعالى
فاتبعوه وقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على
المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فأخبر أنه زوجه بامرأة
زيد ليدل على أنه يجوز لكل أحد أن يتزوج امرأة من تبناه
وأيضا ما روي أن رجلا سأل أم سلمة رضي الله عنها عمن قبل امرأته وهو صائم
فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم ألا أخبرته أني أفعل ذلك
فدل على أن ما كان مباحا له فهو مباح لأمته
وأيضا هو أن الصحابة رضي الله عنهم كانت ترجع في الاستدلال على الأشياء
إلى أفعال رسول الله صلى الله عليه و سلم فدل على ما ذكرناه
واحتجوا بأن ما فعله أو أمر به يجوز أن يكون مصلحة له خاصة لا مصلحة لغيره
فيه فجيب أن لا يتعدى إلى غيره إلا بدليل
والجواب هو أنه لا يجوز ذلك لأن الشرع ورد باتباعه فيه والاقتداء به فوجب
أن يتبع
قالوا ما وجد فيه من الفعل لا يتعداه وما أمر به لا يتناول غيره فوجب أن
لا يشاركه فيه غيره إلا بدليل
والجواب هو أنا قد دللنا على وجوب اتباعه والتسوية بينه وبين غيره في
الأحكام فبطل ما قالوه
مسألة 2
ما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يعلم على وجه فعله وجب التوقف فيه حتى يقوم الدليل عليه في قول أكثر أصحابنا وحكى ذلك عن أبي بكر الدقاق وهو قول أكثر المتكلمينومن أصحابنا من قال يقتضي الندب حكى ذلك عن أبي بكر الصيرفي والقفال والقاضي أبي حامد
وقال بعضهم يحمل ذلك على الوجوب حكي ذلك عن أبي
العباس وأبي سعيد وابن خيران وهو مذهب مالك
لنا أن فعله يحتمل الوجوب والاستحباب والإباحة
والدليل عليه هو أن صورة الفعل في الجميع واحدة وإذا احتمل هذه الوجوه لم
يكن حمله على بعضها بأولى من الحمل على الباقي فوجب التوقف
ولأن القطع فيه بالوجوب أو الندب لا يخلو إما أن يكون من غير اعتبار الوجه
الذي وقع عليه الفعل فيجب أن يقطع بذلك وإن علم أنه فعله على غير ذلك
الوجه وهذا لا يقوله أحد وإما أن يكون القطع مع اعتبار الوجه الذي وقع
عليه الفعل فيجب أن لا يقطع ما لم يعلم الوجه الذي وقع عليه الفعل
واحتج من قال بالندب بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحسن
التأسي يقتضي الندب والاستحباب
قلنا هذا دليل لنا لأن التأسي هو أن تفعل كفعله وهذا لا يعلم من
صورة الفعل فيجب التوقف فيه حتى يرد الدليل
قالوا الندب متيقن لأنه أقل أحوال القرب فوجب أن يحمل اللفظ عليه
قلنا هذا يعارضه بأن في الإيجاب احتياط فوجب أن يحمل اللفظ عليه لأنه ربما
كان واجبا فلا يخرج منه إلا الفعل وإذا بطل هذا في الإيجاب بطل ما قالوه
في الندب
واحتج من ذهب إلى الوجوب بقوله عز و جل فاتبعوه
قلنا الاتباع أن يفعل كفعله
يدلك عليه هو أنه لو فعله على وجه الوجوب وفعلناه على وجه الندب لم نكن
متبعين له وإذا ثبت هذا فإن ما يمكن فيه الاتباع إذا علم وجه الفعل الذي
وقع عليه الفعل فنتبعه فيه فأما ما لم يعلم فيه وجه الفعل فلا يمكن فيه
الاتباع
فإن قيل الخبر يقتضي وجوب المتابعة في الفعل وذلك يمكن وإن لم يعلم حال
الفعل كما تقول في الصلاة فإن تصح المتابعة فيها وإن لم تعلم نية الإمام
قلنا هذا مخالف للمتابعة في الصلاة لأن هناك المتابعة تقع في الأفعال
الظاهرة وذلك يمكن وإن لم تعلم نية الإمام وهاهنا تقع في الفعل على جهته
ألا ترى أنه لو فعله واجبا لم يجز فعله ندبا ولو صلى الإمام صلاة فرض جاز
أن نتبعه في النفل فافترقا
واحتجوا بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره والأمر يقع على
القول وعلى الفعل والدليل عليه قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم وقوله تعالى
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض والمراد بذلك كله الفعل
والجواب هو أن إطلاق الأمر يتناول القول خاصة ولا يحمل على
الفعل من غير دليل
وعلى أن قوله عن أمره كناية والكناية ترجع إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور هو
الله تعالى لأنه قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين
يخالفون عن أمره والظاهر أن الكناية عائدة إليه وأمر الله تعالى هو الذي
يستدعي به الفعل وذلك واجب
ولأن هذا يقتضي أمرا تصح فيه الموافقة وترك المخالفة وهو الذي علم صفته
فيوافقه فيه وهذا إنما يكون فيما علم منه وجه الفعل
واحتجوا بقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول التغابن 6412 ولم يفرق
قلنا الطاعة موافقة الأمر والعصيان مخالفته وهذا إنما يكون فيما علم وجه
الفعل فيه ونحن لا نعلم حال هذا الفعل فلا يدخل في الآية
واحتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم خلع نعله في الصلاة فخلع
الناس نعالهم ثم قالوا رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا فدل على أن متابعته
فيما يفعل واجبة
قلنا هذا خبر الواحد فلا يجوز أن يستدل به على إثبات أصل من الأصول
وعلى أنهم إنما تبعوه في خلع النعل لأنه كان قد أمرهم باتباعه في الصلاة
ألا تراه قال صلوا كما رأيتموني أصلي فلما خلع نعله ظنوا أن ذلك مما شرع
في الصلاة فتبعوه امتثالا لقوله عليه السلام
قالوا روي أن أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه و سلم عام الحديبية انحر
هديك حيث وجدته واحلق فإنهم يحلقون فتبعوه فدل على أن فعله يقتضي الوجوب
قلنا إنما تبعوه في الحلق والذبح لأنه اقترن به دليل من جهة
القول وهو قوله عليه السلام اذبحوا واحلقوا وكلامنا في الفعل المجرد هل
يقتضي الوجوب
قالوا أيضا إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في التقاء الختانين هل يوجب
الغسل فرجعوا إلى فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث روت عائشة رضي
الله عنها فعلته أنا ورسول الله عليه السلام فاغتسلنا
والجواب هو روي أنها روت إذا التقى الختانان وجب الغسل فصاروا في الإيجاب
إلى القول
قالوا ولأنا لا نأمن من أن يكون واجبا فنتركه وذلك لا يجوز فيجب إيجابه
احتياطا
قلنا ولأنا لا نأمن أن لا يكون واجبا فيعتقد وجوبه وذلك لا يجوز
قالوا ولأن البيان تارة يقع بالقول وتارة بالفعل ثم ثبت أن القول يقتضي
الوجوب فكذلك الفعل
قلنا القول له صيغة تدل على الاستدعاء فحمل عليه والفعل ليس له صيغة تدل
على الاستدعاء فوزانه من الأقوال ما لا يدل على الإيجاب كالخبر عن غيره
فلا يحمل على الإيجاب علينا
قالوا ولأنه عليه السلام لا يفعل إلا حقا وصوابا فوجب أن يتبع فيه
قلنا الاتباع إنما يكون بأن تفعل على حسب فعله حتى يكون ذلك حقا وصوابا
وهذا لا يمكن فيما لا نعلم فيه حال الفعل فوجب التوقف
مسألة 3
البيان يصح بالفعل وهو أن يفعل بعض ما دخل تحريمه في العموم ويدل ذلك على تخيص العمومومن أصحابنا من قال لا يجوز البيان بالفعل ولا يخص به العموم وحكي ذلك عن أبي إسحق وهو قول أبي الحسن الكرخي
لنا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولم يفصل وقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم ولم يفرق بين القول والفعل
ويدل عليه هو أنه لما ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة فقصد بفروجهم أمر بأن تحول مقعدته إلى القبلة إلى بيان تخصيص العموم الوارد في التحريم بفعله فدل على أن التخصيص يقع به
ويدل عليه هو أن ما خرج منه ابتداء فهو شرع له ولغيره فكذلك ما خرج بعد العموم
واحتجوا بأن تخصيص العموم أحد نوعي البيان فلا يجوز بفعله كالنسخ
والجواب أن من أصحابنا من أجاز النسخ بفعله وإن سلمنا لم يمتنع
لأن لا يجوز النسخ ويجوز التخصيص ألا ترى أن نسخ الكتاب بالسنة لا يجوز
ويجوز تخصيصه بها فدل على أن الفرق بينهما
قالوا ولأن ما فعله يحتمل أن يكون تخصيصا له ويحتمل أن يكون هو وغيره فيه
سواء فلا يترك العموم المتيقن بأمر محتمل
قلنا هو وإن احتمل الوجهين إلا أن الظاهر أنه هو وغيره فيه سواء فوجب أن
يحمل الأمر على الظاهر
مسألة 4
إذا تعارض القول والفعل في البيان فالقول أولى من الفعلومن أصحابنا من قال الفعل أولى
وذهب بعض المتكلمين إلى أنهما سواء
لنا هو أن القول يدل على الحكم بنفسه والفعل لا يدل بنفسه وإنما يستدل به على الحكم بواسطة وهو أن يقال لو لم يجز ذلك لما فعل لأنه صلى الله عليه و سلم لا يجوز أن يفعل مالا يجوز فكان ما دل على الحكم بنفسه أولى مما دل عليه بواسطة
وأيضا فإن القوى يتعدى والفعل مختلف فيه فمن الناس من قال لا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل فكان ما يتعدى بنفسه بإجماع أولى
ولأن البيان بالقول يستغني بنفسه عن الفعل والبيان بالفعل لا يستغني عن البيان بالقول ألا ترى أنه عليه السلام لما حج وبين المناسك للناس قال لهم خذوا عني مناسككم ولما صلى وبين أفعال الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولما صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه و سلم وبين له المواقيت قال
الوقت ما بين هذين فلم يكتف في هذه المواضع بالفعل حتى ضم إليه
القول فكان تقديم القول أولى
واحتج من قال إن البيان بالفعل أولى بأن النبي عليه السلام سئل عن مواقيت
الصلاة فلم يبين قولا بل قال للسائل اجعل صلاتك معنا وبين له ذلك بالفعل
وكذلك بين المناسك والصلاة بالفعل فدل على أن الفعل آكد
والجواب هو أن هذا يدل على جواز البيان بالفعل ونحن نقول بذلك وإنما
الكلام في تقديم أقوى البيانين وليس في هذا ما يدل على أن الفعل أقوى
قالوا ولأن مشاهدة الفعل آكد في البيان من القول لأن في الفعل من الهيئات
مالا يمكن الخبر عنها بالقول ولا يوقف منه على الغرض إلا بالمشاهدة والوصف
فدل على أن الفعل آكد وأبلغ في البيان
قلنا هذا لا يصح لأنه ما من فعل إلا ويمكن العبارة عن وصفه بالقول حتى
يصير كالمشاهد ولهذا علم النبي صلى الله عليه و سلم المسيء صلاته بالقول
وعبر عما يحتاج إليه من الأفعال
وأما من قال إنهما سواء فاحتج بأن كل واحد منهما يقع به البيان كما يقع
بالآخر وقد بين النبي عليه السلام مرة بالقول ومرة بالفعل فدل على أنهما
سواء
والجواب هو أنهما وإن استويا في البيان إلا أن القول هو الأصل في البيان
والفعل إنما يصير بيانا بغيره والقول مجمع على وقوع البيان به والفعل
مختلف فيه فكان القول أولى بالتقديم
مسائل النسخ
مسألة 1
النسخ جائز ولا يمنع منه عقل ولا شرعوقال أبو مسلم عمرو بن يحيى الأصبهاني النسخ لا يجوز
وهو قول بعض اليهود
لنا قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقوله
تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية وهذا دليل على جواز النسخ
ولأن نكاح الأخوات كان جائزا في شرع آدم صلوات الله عليه ثم حرم ذلك في
شرع غيره فدل على جواز النسخ
ولأن التكليف وإن كان على وجه المصلحة كما قال بعض الناس فيجب أن يجوز
النسخ لأنه يجوز أن تكون المصلحة للعباد في فعل الشيء إلى وقت ثم المصلحة
لهم في تركه في وقت آخر
وإن كان التكليف غير مشروط في المصلحة كما قاله آخرون وإنما يكلف الله
عباده ما شاء وجب أن يجوز النسخ أيضا لأنه يجوز أن يكلفهم في وقت شيئا وفي
وقت آخر غيره
ولأنه إذا جاز أن يخلق الله تعالى خلقه على صفة ثم ينقلهم إلى صفة أخرى
ولم يمنع ذلك من العقل جاز أن يكلفهم فعل العبادة في وقت ثم يسقط ذلك عنهم
في وقت آخر
ولأنه إذا جاز أن يطلق الأمر والمراد به أن يعجز عنه بمرض أو
غيره جاز أن يطلق والمراد به إلى أن ينسخه عنه
ولأنه إذا جاز أن لا يجب الشيء برهة من الزمان لم يرد الشرع بإيجابه جاز
أن يجب برهة من الزمان لم يرد الشرع برفعه وإسقاطه
واحتجوا بأن جواز النسخ يؤدي إلى البداء على الله تعالى وهنا لا يجوز
والجواب هو أن البداء أن يظهر له ما كان خفيا ونحن لا نقول فيما ينسخ إنه
ظهر له ما كان خافيا عليه بل تقول إنه أمر به وهو عالم أنه يرفعه في وقت
النسخ وإن لم يطلعنا عليه فلا يكون ذلك بداء
على أنه لو جاز أن يقال إن ذلك بداء لجاز أن يقال إنه إذا خلق الخلق على
صفة من الطفولية والصغر ثم نقلهم إلى غير ذلك من الأحوال إن ذلك بداء ولما
بطل هذا فيما ذكرناه بطل فيما اختلفنا فيه
قالوا إذا أمر الله تعالى بشيء دل على حسنه وإذا نهى عنه دل ذلك على قبحه
ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد حسنا قبيحا
قلنا إنما يصح هذا إذا قلنا إن النهي تعلق بما تعلق الأمر به فأما إذا
قلنا إن النهي تعلق بما لم يتعلق الأمر لم يؤد إلى ما ذكروه ومتى أمر بشيء
ثم نسخه علمنا بأن الأمر كان إلى ذلك الوقت فلا يكون النهي مما تعلق به
الأمر
ولأنه لو كان هذا دليلا على إبطال النسخ لوجب أن يجعل دليلا على إبطال
التخصيص فيقال إنه إذا أمر بقتل المشركين لا يجوز أن ينهى عن قتل أهل
الذمة لأن الأمر بالقتل يدل على حسنه والنهي عنه يدل على قبحه ولا يجوز أن
يكون الشيء الواحد حسنا قبيحا ولما لم يصلح أن يقال هذا في إبطال التخصيص
لم يصلح أن يقال مثله في إبطال النسخ
قالوا القول بالنسخ يؤدي إلى اعتقاد الجهل لأنه يعتقد وجوب الأمر على
التأبيد وهو على خلاف ما يعتقد
قلنا لا يعتقد الوجوب على التأبيد بل يعتقد وجوبه مالم ينسخ عنه
فلا يؤدي إلى ما ذكروه
واحتج قوم من اليهود بأن موسى عليه السلام قال لهم شريعتي مؤبدة وهذا يمنع
من النسخ
والجواب أن هذا كذب منهم فإن موسى عليه السلام ما قال لهم هذا وإنما لقنهم
ذلك ابن الراوندي
والدليل عليه أنه لو كان هذا أصلا لكان قد احتج به أحبار اليهود على النبي
صلى الله عليه و سلم ولما لم يقل هذا أحد من قدمائهم أنه ذكره دل على كذب
ابتدعوه
مسألة 2
يجوز النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيدوقال بعض المتكلمين لا يجوز النسخ إلا في خطاب مطلق فأما إذا قيد بالتأبيد فلا يجوز نسخه
لنا هو أنه إذا جاز نسخ اللفظ المطلق وإن كان ظاهره التأبيد جاز نسخ ما اقترن به ذكر التأبيد لأن التأبيد يستعمل فيما لا يراد به التأبيد ألا ترى أنك تقول لازم غريمك أبدا وتريد إلى وقت وكذلك هاهنا يجوز أن يقيد بالتأبيد والمراد به إلى وقت النسخ
ولأنه لو كان ذكر التأبيد في الزمان يمنع النسخ لكان ذكر الكل في الأعيا يمنع التخصيص ولما جاز أن يقول اقتلوا المشركين كلهم ثم يخص بعده من المشركين جاز أن يقول افعلوا هذا أبدا ثم ينسخ
ولأنه إذا جاز أن يقيد الخطاب بالتأييد ثم يرد بعده الشرط والاستثناء جاز أن يرد بعده النسخ
ولأنه إذا جاز أن يقيد الخطاب بالتأبيد ويكون معناه ما لم يعجزوا عنه بمرض وغيره جاز أن يقيده بالتأبيد ويكون معناه افعلوا أبدا مالم ينسخ عنكم
واحتجوا بأنه لو جاز النسخ مع ذكر التأييد لم يكن إلى معرفة
مالم ينسخ من الخطاب سبيل ومتى جوزتم ذلك لزمكم أن تقولوا أنه لا يعلم ختم
النبوة برسول الله
والجواب هو أنه يمكن معرفة ذلك بأن نقول المصلحة في هذا الحكم لا تتغير ما
دمتم مكلفين فنعلم بذلك أنه لا يرد عليه النسخ وبمثل هذا يعلم أن النبي
صلى الله عليه و سلم خاتم النبيين وأن شرعه مؤبد
مسألة 3
يجوز النسخ وإن لم يشعر عند التكليف بالنسخوقال بعض الناس لا يجوز إلا أن يقترن بالخطاب ما يدل على النسخ في الجملة
لنا هو أنه لو كان يجب الإشعار بما يزيل الأمر من النسخ لوجب الإشعار بما يحدث من الأمراض المسقطة للأمر ولما لم يجب بيان ذلك لم يجب بيان النسخ
ولأنه لو وجب الإشعار بالنسخ لوجب بيان وقته ولما لم يجب بيان وقته لم يجب بيانه في الجملة
ولأن البيان إنما يجب للحاجة ولا حاجة إلى ذلك عند التكليف فلم يجب
واحتجوا بأن تجويز هذا الأمر يؤدي إلى اعتقاد الجهل فإنه يعتقد وجوب الأمر على الدوام وهو على خلاف ما يعتقد
والجواب هو أنه لا يعتقد وجوب ذلك على الدوام بل يعتقد وجوبه بشرط أن لا يرد عليه ما ينسخه فلا يؤدي إلى اعتقاد الجهل
مسألة 4
يجوز نسخ الشيء إلى مثله وإلى أخف منه وإلى أغلظ منهومن أصحابنا من قال لا يجوز النسخ إلى الأغلظ وهو قول أهل الظاهر
لنا هو أن الله تعالى خير الناس في ابتداء الإسلام بين الصوم وبين الفطر ثم نسخ ذلك بالانحتام وكذلك أمر بحبس الزاني في البيوت ثم نسخه بالجلد والرجم وذلك أغلظ من المنسوخ
ولأن التكليف إن كان على وجه المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في النقل إلى الأغلظ
وإن لم يكن على وجه المصلحة بل يكلف عباده ما شاء فيجوز أن يسقط
عنهم شيئا ويكلفهم ما هو أغلظ منه
ولأنه إذا جاز أن يبتدىء إيجاب تغليظ بعد أن لم يكن واجبا جاز أن يسقط
واجبا ويوجب ما هو أغلظ منه
واحتجوا بأن الله تعالى نسخ آية المصابرة بالتخفيف فقال الآن خفف الله
عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ونسخ قيام الليل بالتخفيف فقال فاقرؤوا ما تيسر
منه
والجواب هو أن هذا يدل على جواز النسخ إلى الأخف ونحن نجيز ذلك وكلامنا في
النسخ إلى الأغلظ وليس فيه ما يمنع منه
مسألة 5
يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعلهوقال الصيرفي لا يجوز وهو قول المعتزلة
لنا هو أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخ ذلك قبل أن يفعله فدل على جوازه
فإن قيل إنما أمره بمقدمات الذبح وهو الإضجاع وتله للجبين وقد فعل ذلك ولهذا قال الله تعالى قد صدقت الرؤيا فدل على أنه فعل المأمور
قيل المأمور به هو الذبح والدليل عليه قوله تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك
ولأنه لو كان المأمور به هو المقدمات لما أظهر إبراهيم عليه السلام الجزع وقد
أظهر الجزع من ذلك فقال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا
ترى
ولأن إسماعيل عليه السلام أظهر التجلد والصبر فقال ستجدني إن شاء الله من
الصابرين والمقدمات لا يحتاج فيها إلى الصبر والتجلد
ولأنه قال إن هذا لهو البلاء المبين وليس في المقدمات بلاء
ولأنه لو كان المأمور به قد فعل لما احتاج إلى الفداء وقد قال الله تعالى
وفديناه بذبح عظيم وأما قوله قد صدقت الرؤيا فالمراد به أنك قد آمنت بذلك
وعزمت على فعله فدل عليه التصديق إنما يكون بالقلب
فإن قيل قد فعل المأمور به وهو الذبح ولكن كلما قطع جزءا التحم
قيل ولو كان هذا صحيحا لكان قد ذكره الله تعالى فإن ذلك من الآيات العظيمة
ولأنه لو كان كذلك لما احتاج إلى الفداء ويدل عليه هو أنه إذا جاز أن يأمر
بأفعال متكررة في الأزمان لم ينسخ ذلك في بعض الأزمان وإن لم يمض وقت جميع
ما تناوله الأمر جاز أن يأمر بفعل واحد ثم ينسخ ذلك قبل دخول وقته
ولأنه إن كان التكليف على حسب المصلحة كما قال بعضهم جاز أن تكون المصلحة
في إيجاب الاعتقاد وإظهار الطاعة في الالتزام والعزم على الفعل
وإن كان على حسب ما يشاء من غير اعتبار المصلحة كما قال آخرون فيجوز أن
يكون قد شاء أن يكلفهم ما ذكرناه ولا يشاء الفعل ولهذا أمر إبراهيم عليه
السلام بذبح ابنه ولم يرد الفعل وإنما أراد منه ما ذكرناه
ولأنه إذا جاز أن يأمر الإنسان بفعل العبادة مع علمه بأنه يموت أو يعجز
عنه
قبل أن يدخل وقتها ولم يقبح جاز أن يأمر بفعلها ثم يسقط ذلك عنه
قبل فعلها
واحتجوا بأن الأمر من الله سبحانه يدل على أن المأمور به صلاح للمأمور وما
كان صلاحا لهم لا يجوز للحكيم أن ينهاهم عنه ويمنعهم منه
والجواب هو أن الأمر يدل على الصلاح ما دام الأمر قائما فإذا نهى عنه
علمنا أنه كان الصلاح إلى غاية
ولأنه لو كان هذا دليلا على المنع من النسخ قبل الفعل لوجب أن يجعل دليلا
على إبطال النسخ أصلا فيقال إن الأمر من الحكيم يدل على كونه صلاحا للعبيد
وما كان صلاحا للعبيد لم يجز للحكيم أن ينهاهم عنه وإذا بطل هذا في إبطال
النسخ بطل فيما ذكروه
وربما قالوا إن الأمر بالشيء يقتضي حسن المأمور به والنهي عنه يقتضي قبحه
ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد حسنا قبيحا
والجواب نحو ما تقدم
قالوا لأن هذا يؤدي إلى البداء على الله تعالى وذلك لا يجوز
فالجواب هو أن البداء أن يظهر ما كان خافيا عليه والله تعالى لما أمر كان
عالما بالوقت الذي ينسخه عنهم فلا يؤدي إلى ما ذكروه
قالوا ولأنه لو جاز أن ينسخ الشيء قبل وقت الفعل لجاز أن يرد الأمر مع
النهي موضعا واحد فيقول افعلوا كذا وكذا ولا تفعلوه ولما لم يجز هذا لم
يجز ما نحن فيه
قلنا إذا ورد الأمر مقرونا بالنهي لم يفد شيئا وليس كذلك هاهنا فإنه إذا
تراخى النهي كان الأمر مفيدا لأنه يتضمن وجوب الاعتقاد والعزم على الفعل
فافترقا
قالوا مقتضى الأمر الفعل فإذا لم يرد مقتضاه كان لغوا فلم يصلح
الخطاب كما لو قال اقتلوا وأراد به لا تقتلوا
قلنا هذا يبطل بالأمر المطلق في الأزمان فإن مقتضاه الفعل على الدوام فإذا
نسخ بعد الفعل لم يرد مقتضاه ثم لا يصير لغوا
وعلى أنا لا نسلم أن مقتضى هذا الأمر الفعل فإن أوامر صاحب الشرع مشروطة
بما يقوم عليه الدليل من نسخ وعجز وغير ذلك فمتى قام الدليل على النسخ
علمنا أن مقتضى الأمر مالم يرد النهي عنه فإذا نهى عنه فقد أراد باللفظ ما
اقتضاه فلا يكون هذا لغوا ويخالف هذا إذا قال اقتلوا وأراد به لا تقتلوا
لأن هذا المراد لا يصح شرطه في الكلام ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول اقتلوا
لا تقتلوا وليس كذلك هاهنا فإنه يصح أن يشترط في الأمر ما يرد بعده من
النهي بأن يقول افعلوا إلى أن أنهاكم عنه فدل على الفرق بينهما
مسألة 6
لا يجوز نسخ القرآن بالسنة آحادا كانت أو متواترةوقال أبو العباس بن سريج يجوز بالسنة المتواترة ولكنه لم يوجد في الشرع
وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز ذلك بالأخبار المتواترة
وذهب بعض الناس إلى جواز ذلك بالمتواترة والآحاد وهو مذهب بعض أهل الظاهر
لنا قوله تعالى ما ننسخ من آية أو نفسها نأت بخير منها أو مثلها فأخبر أنه
لا ينسخ آية إلا بمثلها أو بخير منها والسنة ليست مثل القرآن ولا هي خير
منه فوجب أن لا يجوز النسخ بها
فإن قيل المراد نأت بخير منها أو مثلها في الثواب وقد يكون في السنة ما هو
خير من المنسوخ في الثواب
قيل هذا لا يصلح لوجوه
منها أنه قال نأت بخير منها وهذا يقتضي أن يكون هو الذي يأتي به والسنة
إنما يأتي بها النبي عليه السلام
ولأنه قال في سياق الآية ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير والذي يختص
الله بالقدرة عليه هو القرآن
ولأن المثل يقتضي أن يكون المثل من جنس المنسوخ كما إذا قال لا
آخذ منك ثوبا إلا أعطيتك خيرا منه اقتضى خيرا منه من جنسه
ولأنه قال نأت بخير منها أو مثلها وهذا يقتضي أن يكون المثل من جنس
المنسوخ كما إذا قال لا أخذ منك ثوبا إلا أعطيتك خيرا منه اقتضى خيرا منه
من جنسه
ولأن المثل يقتضي أن يكون مثله من كل وجه والسنة قط لا تماثل القرآن في
الثواب في تلاوته ولا في الدلالة على صدق النبي عليه السلام بنظمه
فإذا قيل لو كانت السنة لا تماثل القرآن فالقرآن أيضا لا يكون بعضه خيرا
من بعض فيجب أن يكون المراد به الأحكام
قيل قد يكون بعض القرآن خيرا من بعض في الثواب ألا ترى أن سورة الإخلاص
ويس وغيرهما أفضل من غيرهما من القرآن في الثواب وقد يكون بعضها أظهر في
الإعجاز من بعض ألا ترى أن قوله عز و جل وقيل يا أرض ابلعي ماءك وياسماء
أقلعي أبلغ في الإعجاز من غيره
فإن قيل قوله نأت بخير منها ليس فيه أن ما يأتي به هو الناسخ ويجوز أن
يكون الناسخ غيره
قلنا قوله تعالى ما ننسخ من آية شرط وقوله نأت بخير منها جزاء ولهذا جزم
قوله ما ننسخ وإذا كان كذلك وجب أن يكون ما يأتي به لأجله وبدلا عنه كما
إذا قال ما تصنع اصنع وما آخذه أعط مثله اقتضى أن يكون الجزاء لأجل الشرط
وبدلا عنه فدل على أنه هو الناسخ
فإن قيل النسخ إنما يقع في الحكم لا في التلاوة ولا مفاضلة بين
حكم الكتاب وحكم السنة وإنما المفاضلة بين لفظيهما والنسخ لا يقع إلا في
اللفظ
قيل الخلاف في نسخ التلاوة والحكم واحد فإن عندهم لو تواترت السنة بنسخ
التلاوة وجب النسخ بها ولا مماثلة بينهما وعلى أن نسخ الحكم أيضا يقتضي
نسخ الآية ألا ترى أنه إذا نسخ حكم الآية قيل هذه آية منسوخة فيجب أن لا
يكون ذلك إلا بمثلها أو بخير منها
ويدل عليه هو أن السنة فرع للقرآن ألا ترى أنه لولا القرآن لما ثبتت السنة
فلو جوزنا نسخ القرآن بها لرفعنا الأصل بفرعه وهذا لا يجوز ولأن السنة دون
القرآن في الرتبة ألا ترى أنها لا تساويه في الإعجاز في لفظه ولا في
الثواب في تلاوته فلم يجز نسخ بها ويدلك عليه أن القياس لما كان دون الخبر
في الرتبة لم يجز نسخه به فكذلك هاهنا
واحتجوا بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم والنسخ
بيان للمنزل فيجب أن يكون ذلك بيانا له
والجواب هو أن البيان يراد به الإظهار والتبليغ ألا ترى أنه علقه على جميع
القرآن والنسخ لا يجوز أن يتعلق بجميع القرآن فدل على أن المراد به ما
ذكرناه
ولأن النسخ ليس بيانا للمنسوخ وإنما هو إسقاط ورفع فلا يدخل في الآية
قالوا ولأنه دليل مقطوع بصحته فجاز نسخ القرآن به كالقرآن
قلنا هذا يبطل بالإجماع فإنه مقطوع بصحته ثم لا يجوز النسخ به
وعلى أنه لا يمتنع أن يتساوى القرآن والسنة في القطع ثم يجوز النسخ
بأحدهما دون الآخر ألا ترى أن الخبر والقياس يتساويان في أن كل واحد منهما
مظنون ثم يصح النسخ بأحدهما دون الآخر
ثم المعنى في القرآن أنه يماثل المنسوخ في التلاوة والإيجاز فجاز نسخه به
وليس كذلك هاهنا فإن السنة دون القرآن في الثواب والإعجاز فلم يجز نسخه
بها
قالوا ولأن النسخ إنما يتناول الحكم والكتاب والسنة المتواترة في إثبات
الحكم واحد وإن اختلفا في الإعجاز فيجب أن يتساويا في النسخ
قلنا هما وإن تساويا في إثبات الحكم إلا أن أحدهما أعلى رتبة من الآخر
فجاز أن يختلفا في النسخ ألا ترى أن الخبر والقياس يتساويان في إثبات
الحكم ثم يجوز نسخ السنة بأحدهما دون الآخر لما اختلفا في الرتبة فكذلك
هاهنا
قالوا ولأن المانع من ذلك لا يخلو إما أن يكون فضله على السنة في الثواب
أو فضله عليها في الإعجاز ولا يجوز أن يكون المانع بفضل الثواب لأنه يجوز
نسخ أكثر الآيتين ثوابا بأقلهما ولا يجوز أن يكون المانع فضل الإعجاز لأنه
يجوز نسخ الآية المعجزة بالآية التي لا إعجاز فيها وإذا بطل هذان الوجهان
لم يبق ما يتعلق به المنع فوجب أن يجوز
قلنا المانع عندنا معنى آخر وهو رفع كلام الله تعالى بغير كلامه
وهذا لم يدلوا على إبطاله
أو المانع من ذلك رفع الأصل بفرعه وهذا أيضا لم يدلوا عليه
ولأنا لو جعلنا المانع ما ذكروه من فضل القرآن على السنة بالإعجاز لصح وما
ذكروه من نسخ الآية المعجزة بغير المعجزة لا يصح لأن الناسخ كالمنسوخ في
الإعجاز ألا ترى أن كل واحد منهما إذا طال وكثر كان معجزا وإذا لم يطل لم
يكن معجزا
واحتج من أجاز النسخ بأخبار الآحاد خاصة أن ما جاز نسخ السنة به جاز نسخ
القرآن به كالقرآن
والجواب هو أنه ليس إذا أجاز أن يسقط به مثله جاز أن يسقط به ما هو أقوى
منه ألا ترى أن القياس يجوز أن يعارض مثله ولا يجوز أن يعارض الخبر
قالوا ولأن النسخ إسقاط لبعض ما يقتضيه ظاهر القرآن فجاز بالسنة كالتخصيص
والجواب هو أنه لا يمتنع أن يجوز التخصيص به ولا يجوز النسخ به ألا ترى أن
تخصيص الخبر بالقياس جائز ونسخه به لا يجوز
ولأن التخصيص إسقاط بعض ما اشتمل عليه اللفظ بعمومه فجاز تركه بخبر الواحد
وليس كذلك النسخ فإنه إسقاط اللفظ بالكلية فلم يجز بما دونه
قالوا ولأنه إذا جاز النسخ إلى غير بدل فجوازه إلى بدل ثبت بلفظ دونه أولى
قلنا لو كان هذا صحيحا لوجب أن يجوز بالقياس فيقال إنه إذا جاز رفعه إلى
غير بدل فلأن يجوز إلى بدل يثبت بالقياس أولى
ولأن النسخ إلى غير بدل لا يؤدي إلى إسقاط القرآن بما دونه لأنه يجوز أن
يكون قد نسخ بمثله أو بما هو أقوى منه والنسخ بالسنة يؤدي إلى
إسقاط القرآن ورفعه بما هو دونه وهذا لا يجوز
قالوا ولأنه قد وجد في القرآن آيات منسوخة بأخبار الآحاد ووجود ذلك يدل
على جوازه فمن ذلك
الوصية للوالدين والأقربين نسخه قوله عليه السلام لا وصية لوارث
ونسخ الحبس في حق الزاني بقوله عليه السلام والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب
عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم
ونسخ قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام بقوله عليه السلام اقتلوا
ابن خطل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة
ونسخ قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
بما روي أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور
ونسخ قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بقوله عليه السلام لا تنكح
المرأة على عمتها ولا على خالتها
والجواب هو أن الوصية نسخت بآية المواريث ولهذا قال عليه السلام إن الله
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
وآية الحبس نسخت في البكر بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
منهما مائة جلدة وفي الثيب بآية الرجم التي كانت في الكتاب ونسخ رسمها وهي
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله
وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام نسخ بقوله فاقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم
وقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما فالمراد به ما هو مستطاب عندهم وليس
ذلك من الخبائث فهو عموم دخله التخصيص
وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم فهو عموم دخل التخصيص بالخبر وإذا أمكن
البناء والجمع لم يصح حمله على النسخ فسقط ما قالوه
مسألة 7
يجوز نسخ السنة بالقرآن في أحد القولين وفيه قول آخر أنه لا يجوزلنا هو أنه قد وجد ذلك في الشرع فإن النبي عليه السلام صالح قريشا على رد من جاءه من المسلمين فرد جماعة ثم جاءته امرأة فمنعه الله تعالى من ردها ونسخ ذلك بقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار وكذلك كانت
الصلوات تؤخر عن أوقاتها في حال الخوف ثم نسخ ذلك بقوله تعالى
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فدل على جوازه
ولأن القرآن أقوى من السنة فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فبالقرآن أولى
واحتجوا بأن الله تعالى جعل السنة مبينة للكتاب فقال لتبين للناس ما نزل
إليهم فلا يجوز أن يجعل الكتاب مبينا للسنة
قلنا يجوز أن تكون السنة مبينة للكتاب ثم تبين السنة بالكتاب كما أن السنة
تخص الكتاب ثم تخص السنة بالكتاب
قالوا ولأنه نسخ شيء بغير جنسه فلا يجوز كنسخ الكتاب بالسنة
قلنا إنما لم يجز نسخ الكتاب بالسنة لأن الكتاب أعلى رتبة من السنة لا
لأنه من غير جنسه يدلك عليه أن نسخ المتواتر بخبر الواحد لا يجوز حين
اختلفا في الرتبة وإن كانا من جنس واحد فدل على أن العلة فيه ما ذكرنا
مسألة 8
لا يجوز النسخ بالقياسوقال أبو القاسم الأنماطي يجوز بالقياس الجلي
لنا هو أنه قياس فلا ينسخ به كالقياس الخفي ولأن النص يسقط القياس إذا عارضه وما أسقط غيره لم يجز نسخه به كنص القرآن لما أسقط نص السنة لم يجز نسخه بالسنة كذلك ههنا
واحتجوا بأن القياس الجلي في معنى النص بدليل أنه ينقض به حكم الحاكم فإذا جاز النسخ بالنص جاز به
قلنا النص لا يسقط النص إذا عارضه فجاز النسخ به وليس كذلك القياس فإنه لو عارضه أسقطه فلم يجز نسخه به
مسألة 9
إذا ثبت الحكم في عين لعلة وقيس عليها غيرها ثم نسخ الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعهومن أصحابنا من قال لا يبطل الحكم في فروعه وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة
لنا أن الحكم في الفرع إنما ثبت لثبوته في الأصل فإذا بطل الحكم في الأصل وجب أن يبطل في الفرع
ألا ترى أن الحكم إذا ثبت بالنص لما كان ثبوته لأجله إذا نسخ النص سقط الحكم به كذلك هاهنا
ولأن الحكم في الفرع يفتقر إلى أصل وإلى علة ثم ثبت أن زوال العلة يوجب زوال الحكم فكذلك زوال الأصل يجب أن يوجب زوال الحكم
واحتجوا بأن هذا إثبات نسخ في الفرع بالقياس على الأصل والنسخ بالقياس لا يجوز
والجواب أنا لا نقول أن ذلك نسخ بالقياس وإنما هو إزالة حكم لزوال موجبه ولو كان ذلك نسخا بالقياس لوجب إذا زالت العلة وزال حكمها أن يقال إن ذلك نسخ من غير ناسخ وهذا لا يجوز ولما لم يصح أن يقال هذا في العلة إذا زالت لم يصح أن يقال ذلك في الأصل إذا زال
قالوا ولأن الفرع لما ثبت فيه الحكم صار أصلا فيجب أن لا يزول الحكم فيه بزواله في غيره
قلنا لا نسلم أنه صار أصلا بذلك وإنما هو تابع لغيره ثبت الحكم فيه لأجله فإذا سقط حكم المتبوع سقط حكم التابع
مسألة 10
الزيادة في النص ليست بنسخوقال أصحاب أبي حنيفة إن كانت الزيادة توجب تغيير الحكم المزيد عليه في المستقبل كان نسخا وإن لم تقتض ذلك لم يكن نسخا ومنعوا بذلك زيادة التغريب في آية الجلد وزيادة الغرم في آية السرقة وزيادة النية والترتيب في آية الوضوء بأخبار الآحاد والقياس
وقال بعض المتكلمين إن كانت الزيادة شرطا في المزيد حتى لا يجزىء ما كان مجزئا إلا بالزيادة وإذا لم تنضم إليه وجب
الاستئناف كزيادة ركعتين على ركعتين كان نسخا وإن لم تكن
الزيادة شرطا في المز لم تكن نسخا
لنا هو أن النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة ثم خص في الشرع ببعض ما
تناوله الاسم فقيل هو رفع الحكم الثابت بالنص وهذه الحقيقة لا توجد فيما
زيد فيه لأن الحكم الثابت بالنص باق كما كان لم يزل ولم يرتفع وإنما لزمه
زيادة فلم يكن ذلك نسخا يدلك عليه أنه لو كان في الكيس مئة درهم فزيد عليه
شيء آخر لم يكن ذلك رفعا لما في الكيس كذلك هاهنا
وأيضا هو أنه لو كانت الزيادة في الحكم نسخا لحكم المزيد عليه لوجب إذا
أوجب الله تعالى الخمس صلوات ثم أوجب صوم شهر رمضان أن يكون ذلك نسخا
للصلوات ولما لم يكن ذلك نسخا بالإجماع وجب أن لا تكون هذه الزيادة نسخا
لأن النسخ ما لم يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ في اللفظ كما لو قال صل إلى
بيت المقدس ولا تصل لم يكن كلاما وهنا لو جمع بين الزيادة والمزيد عليه صح
ووجب الجمع بينهما فدل على أن ذلك ليس بنسخ
ولأن النسخ أن يتناول الناسخ ما تناوله المنسوخ وإيجاب الزكاة لا يتناول
حكم المنسوخ فلا يجوز أن يكون ذلك نسخا له
ولأن الغرض في هذه المسألة إثبات الزيادة في القرآن بخبر الواحد والقياس
والدليل على جواز ذلك هو أن ما جاز تخصيص القرآن به جازت
الزيادة به فيه كالقرآن والخبر المتواتر
ولأنه إذا جاز التخصيص به وهو إسقاط بعض ما تناوله فالزيادة بذلك أولى
ولأن الزيادة على النص لا يتناولها لفظ النص فكان حكمها حكم ما قبل ورود
النص فجاز إثباته بخبر الواحد والقياس
واحتج أصحاب أبي حنيفة بأن النسخ تغيير الحكم عما كان عليه وقد وجد
التغيير بالزيادة لأنه إذا زاد في حد القذف عشرين فقد صار الثمانون بعض
الواجب وكان يتعلق به رد الشهادة وصار لا يتعلق به رد الشهادة فصار كسائر
أنواع النسخ
والجواب هو أنا لا نسلم أن النسخ هو التغيير بل النسخ هو الإزالة والرفع
من قولهم نسخت الشمس الظل إذا أزالته ونسخت الرياح الآثار إذا ذهبت بها
وهذا لا يوجد إلا في إسقاط ما كان بتاتا
ولو سلمنا أن النسخ هو التغيير لم نسلم أن الواجب تغير عما كان عليه بل هو
على ما كان عليه
وأما قوله إذا صار الواجب بعض الواجب وكان ترد به الشهادة وصار لا ترد به
الشهادة يبطل به إذا أمر بالصلاة ثم أمر بالصوم لأن الأول كان جميع الواجب
وصار بعض الواجب وكان تقبل الشهادة بفعلها فصار لا تقبل الشهادة إلا
بفعلها مع غيرها ثم لا يكون ذلك نسخا
ويبطل به إذا سقط بعض الثمانين من الحد فإنه قد صار الباقي كل
الواجب وكان بعض الواجب فترد به الشهادة وقد كان لا ترد به ثم لا يكون ذلك
نسخا للباقي
قالوا إذا ثبتت الزيادة صار جزءا من المزيد عليه وحكمه حكمه فيجب أن لا
يثبت إلا بما ثبت به المزيد عليه
قلنا لعمري إنه يصير جزاء منه على معنى أنه يجب ضمه إليه ولكن لا يجب أن
يثبت بالطريق الذي ثبت به المزيد عليه
يدلك عليه أن كونه جزءا منه ليس بأكثر من إثبات صفة المزيد عليه ويجوز أن
تكون الصفة تخالف الموصوف في طريقه فيثبت الشيء بطريق مقطوع به وصفته من
الإيجاب وغيره يثبت بطريق غير مقطوع به
قالوا ولأن التقدير بالعدد موضوع للمنع من الزيادة فإذا وردت الزيادة
أفادت إيجاب ما كان ممنوعا منه وهذا حقيقة النسخ وهو أن يجعل ما كان
محظورا مباحا أو واجبا
قلنا هذا على أصلكم لا يصح لأن التقدير بالعدد لا يقتضي المنع من الزيادة
وإنما يصح هذا على أصلنا فلا جرم إذا ورد على ذلك زيادة جعلنا ذلك نسخا
للمنع من الزيادة ونحن لا ننكر نسخ الزيادة فيما أفاد الخطاب حكما في
الزيادة وإنما ننكر أن نجعل الزيادة ناسخة للمزيد عليه وهذا لا سبيل إليه
قالوا لا خلاف أن النقصان من النصوص عليه يوجب النسخ فكذلك الزيادة
قلنا قد جعل النقصان حجة لنا لأنه لا يوجب حكم الباقي من الحد
فيجب أن تكون الزيادة مثله وإنما جعلنا النقصان نسخا لما نقص
لأنه إسقاط حكم ثابت باللفظ وهاهنا زيادة على الحكم الثابت فلم يكن نسخا
يدلك عليه هو أنه لو أوجب الصلاة ثم رفعها كان ذلك نسخا لها ولو زاد على
الصلاة الصوم لم يكن ذلك نسخا للصلاة
واحتجت الطائفة الأخرى أنه إذا كانت الزيادة شرطا كانت مغيرة لحكم المزيد
ألا ترى أنه إذا زاد في الصلاة ركعتين ثم صلى بعد الزيادة ركعتين لم يجزه
وقد كان يجزي ولا يجوز أن يسلم من ركعتين وقد كان يجوز ذلك وهذا حقيقة
النسخ
والجواب أن المزيد عليه باق كما كان لم يتغير وما تعلق بالزيادة من
الإجزاء وعدم الإجزاء والصحة وعدم الصحة لا يوجب النسخ مع بقاء المزيد
عليه ألا ترى أنه إذا زيد في عدد الحد فقد تغير بهذه الزيادة حكم وهو أنه
ما كان مطهرا صار غير مطهر وما كان مكفر صار غير مكفر ثم لا يوجب ذلك نسخ
المزيد عليه
وكذلك إذا زيد في العدة صار ما كان مبيحا غير مبيح ثم لا يعد ذلك نسخا
فبطل ما قالوه
وعلى أنه يبطل بزيادة شرط في الصلاة منفصل عنها أو نقصان شرط كالطهارة في
الصلاة فإنه سلم هذا القائل أنه ليس نسخ للصلاة ومعلوم أنه قد صار ما كان
مجزئا غير مجزىء وما كان صحيحا غير صحيح فسقط ما قالوه
مسألة 11
إذا نسخ بعض العبادة لم يكن ذلك نسخا للباقي وبه قال الكرخي والبصريوذهب بعضهم إلى أن النقصان من العبادة نسخ للباقي
وقال بعض المتكلمين إن كان ذلك نسخ شرط منفصل عن الجملة لم يكن نسخا للجملة
وإن كان نسخ بعض الجملة كالقبلة والركوع والسجود من الصلاة كان نسخا للعبادة
لنا ما بيناه في المسألة قبلها وأن الباقي من الجملة على ما كان الحكم عليه لم يزل فلم يجز أن يكون الجميع منسوخا كما لو أمر بصلاة وصوم ثم نسخ أحدهما
ولأنه لو كان نسخ بعضها نسخا للجميع لكان تخصيص بعضها تخصيصا للجميع ولما بطل أن يقال هذا في التخصيص بطل أن يقال مثله في النسخ
واحتج المخالفون في هذه المسألة بما بيناه في المسألة قبلها وقد مضى الجواب عنه فأغنى عن الإعادة
مسألة 12
إذا نزل النسخ على رسول الله صلى الله عليه و سلم ثبت النسخ في حق النبي عليه السلام وفي حق الأمة في قول بعض أصحابناومن أصحابنا من قال لا يثبت في حق الأمة قبل أن يتصل ذلك بهم وهو قول أصحاب أبي حنيفة
لنا هو أنه إسقاط حق لا يعتبر فيه رضاء من يسقط عنه فلا يعتبر فيه علمه كالطلاق والعتاق والإبراء
ولأنه إباحة لمحظور عليه فجاز أن يثبت حكمه قبل العلم كما إذا قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق وأذن لها وهي لا تعلم ثم خرجت فإنه يثبت حكم الإباحة ولا يقع الطلاق فكذلك هاهنا
ولأن الإباحة تارة تكون من الله تعالى وتارة تكون من جهة الآدمي
ثم الإباحة من جهة الآدمي يثبت حكمها قبل العلم وهو إذا قال أبحت ثمرة
بستاني لكل أحد فكذلك الإباحة من جهة الله تعالى
واحتجوا بأن أهل منى بلغهم القبلة وقد صلوا ركعة فاستداروا في صلاتهم ولم
يؤمروا بالإعادة ولو كان قد ثبت حكمه في حقهم قبل أن يتصل بهم لبطلت
صلاتهم ولأمروا بالإعادة
والجواب هو أن القبلة يجوز تركها بالأعذار ألا ترى أنه يجوز تركها مع
العلم بها في النوفل في السفر ولهذا لم يؤمروا فيها بالإعادة وليس كذلك
غيرها من الأحكام فإنه لا يجوز تركها مع العلم بها فلم يجز أن يسقط حكمها
بالجهل بها
قالوا ولأن من لا علم له بالخطاب لا يثبت الخطاب في حقه كالنائم والمجنون
والجواب هو أن النائم والمجنون حجة لنا فإن الخطاب قد ثبت في حقهما وإن لم
يعلما بالخطاب ألا ترى أن كثيرا من العبادات يثبت وجوبها في حقهما ويجب
عليهما فعلها بعد الانتباه والإفاقة ولو لم يثبت الخطاب في حقهما لما وجبت
تلك العبادات عليهما بعد الانتباه والإفاقة
قالوا ولأنه لو جاز ثبوت الخطاب قبل العلم به لثبت ذلك قبل نزول الوحي به
ولما لم يثبت ذلك قبل نزول الوحي لم يثبت قبل العلم
قلنا قبل نزول الوحي لم يثبت له أحكام الدنيا وليس كذلك بعد
نزول الوحي به فإنه قد ثبت كونه شرعا فثبت في حق كل أحد
قالوا ولأنه لو ثبت حكم الخطاب قبل العلم به لتعلق المأثم بمخالفته كما
تعلق به بعد العلم ولما لم يتعلق المأثم بمخالفته دل على أنه لا يثبت حكمه
قلنا لا يمتنع أن لا يثبت المأثم ويثبت حكم الخطاب ألا ترى أنه إذا علم
بالخطاب ثم نسيه أو نام عنه لم يلحقه المأثم ثم حكم الخطاب يثبت في حقه
قالوا ولأنه مخاطب بالمنسوخ وإذا تركه صار عاصيا فلا يجوز أن يكون حكم
الناسخ ثابتا في حقه
والجواب هو أنه ليس إذا كان مخاطبا بالأمر الأول وتعلق العصيان بمخالفته
دل على أن الخطاب الثاني غير ثابت في الحكم في حقه
ألا ترى أن المرأة بعد الطلاق وقبل أن يتصل ذلك بها مخاطبة بأحكام الزوجية
وعاصية بالمخالفة ثم حكم الطلاق ثابت في حقها فكذلك هاهنا يجوز أن يكون
مخاطبا بالأمر الأول عاصيا بمخالفته ثم حكم الخطاب الثاني قائم في حقه
مسألة 13
شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت نسخهوقال بعض أصحابنا شرع من قبلنا ليس بشرع لنا
ومنهم من قال شرع إبراهيم خاصة شرع لنا وما سواه ليس بشرع لنا
لنا قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده
فإن قيل المراد به التوحيد والدليل عليه هو أنه أضافه إلى الجميع والذي
يشترك الجميع فيه هو التوحيد فأما الأحكام فإن الشرائع فيها مختلفة فلا
يمكن اتباع الجميع فيه
قيل اللفظ عام في التوحيد وفي الأحكام فيجب أن يحمل على الجميع إلا ما خصه
الدليل
ولأن مجيء رسول الله صلى الله عليه و سلم غير مناف لما تقدم من الشرائع
وكل شرع لم يرد عليه ما ينافيه وجب البقاء عليه والدليل عليه شريعة الرسول
عليه السلام
ولأنه يمكن الجمع بين ما جاء به الرسول عليه السلام وبين ما قبله وكل
حكمين أمكن الجمع بينهما لم يصح إسقاط أحدهما بالآخر كإيجاب الصوم والصلاة
في شريعتنا
ولأن الله تعالى حكى شرع من قبلنا ولو لم يقصد التسوية بيننا وبينهم لم
يكن لذكرها فائدة
واحتجوا بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فدل على أن كل واحد منهم
ينفرد بشرع لا يشاركه فيه غيره
والجواب هو أن مشاركتهم في بعض الأحكام لا يمنع من أن يكون لكل واحد منهم
شرع يخالف شرع الآخر كما أن مشاركتهم في التوحيد لا تمنع انفراد كل واحد
منهم بشريعة تخالف شريعة غيره
واحتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى عمرا رضي الله عنه ومعه
شيء
من التوراة ينظر فيه فقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي
فدل على نسخ ما تقدم
والجواب هو أنه إنما نهاه عن النظر في التوراة لأنه مبدل مغير وكلامنا
فيما حكى الله عن دينهم في الكتاب أو ثبت عنهم بخبر الرسول عليه السلام
قالوا ولأن الشرائع إنما شرعت لمصلحة المكلفين وربما كانت المصلحة لمن
قبلنا في شيء والمصلحة لنا في غيره فلا يجوز إجراء حكمهم علينا
قلنا فيجب أن تقولوا يقتضي هذا الدليل أن ما شرع للصحابة لا يكون شرعا
للتابعين لأنه يجوز أن تكون المصلحة للصحابة في ذلك دون التابعين ولما بطل
هذا بالإجماع بطل ما ذكروه
وعلى أن الظاهر أن المصلحة لنا فيما شرع لهم إذ لو كانت المصلحة لنا في
غيره لنسخ ذلك ولما لم ينسخ ذلك دل على أننا وهم في المصلحة سواء
قالوا لو كان شرعا لنا لوجب اتباع أدلتهم وتتبع كتبهم كما يجب ذلك في
شرعنا ولما لم يجب ذلك دل على أن شرعهم لا يلزمنا
قلنا نحن إنما نجعل شرعهم شرعا لنا فيما ثبت بخبر الله تعالى وخبر رسوله
عليه السلام واتباع ذلك واجب وتتبع ما يوصل إلى معرفته واجب فأما مالم
يثبت فليس شرعا لنا فلا يلزمنا اتباعه والكشف عنه
وربما قالوا لو كان شرعهم شرعا لوجب أن يعرف شرعهم أو معاني كلامهم لجواز
أن يكون هنالك ما هو منسوخ أو مخصوص
والجواب عنه أنه إنما يجب من شرعهم ما أخبر الله تعالى عنه وما
أخبر الله تعالى عنه لفظه معروف والظاهر أنه غير منسوخ ولا مخصوص فوجب
العمل به
قالو العبادات في شريعتهم مختلفة فلا يمكن اتباع الجميع فيها فسقطت
قلنا إنما يجب المصير عندنا إلى مالم يثبت فيه اختلاف وأما ما اختلف في
ذلك عمل بالمتأخر منهما كما يفعل ذلك في شرعنا
قالوا ولأن كل شريعة من الشرائع مضافة إلى قوم وهذه الإضافة تمنع أن يكون
غيرهم مشاركا لهم فيها
قلنا ما أنكرتم أن يكون أضيف كل شرع من ذلك إلى قوم لأنهم أول من خوطبوا
به فعرف الشرع بهم وأسند إليهم ويحتمل أن يكون أضيف كل شرع إلى قوم لأنهم
متعبدون بجميعه وغيرهم يشاركهم في بعض الأحكام فلم يضف إليهم وإذا احتمل
أن تكون الإضافة لما ذكرنا سقط التعليق به
قالوا ولأنه لو كان النبي عليه السلام متعبدا بشريعة من قبلنا لوجب أن لا
يقف الظهار والميراث لانتظار الوحي لأن هذه الحوادث أحكامها في التوراة
ظاهرة
قلنا إنما توقف لأن التوراة مغيرة مبدلة فلم يمكن الرجوع إلى ما فيها
فانتظر الحكم من جهة الوحي
وعلى أنه إن كان في بعض الأحكام توقف ففي بعضها عمل بما ثبت من شرع من
قبله ألا ترى أنه صلى إلى بيت المقدس بشرع من قبله فسقط ما قالوا
مسائل الأخبار
مسألة 1
للخبر صيغة تدل عليه بنفسه في اللغةوقالت الأشعرية ليس للخبر صيغة تدل عليه بنفسه
وقالت المعتزلة الخبر إنما يصير خبرا بشرط أن ينضم إلى اللفظ قصد المخبر إلى الإخبار به كما قالوا في الأمر والنهي
لنا هو أن أهل اللسان قسموا الكلام فقالوا أمر ونهي وخبر واستخبار
فالأمر قولك افعل
والنهي قولك لا تفعل
والخبر قولك زيد في الدار
والاستخبار قولك أزيد في الدار
وهذا يدل على أن اللفظ موضوع للخبر يدل عليه بنفسه
واحتجوا بأن هذه الصيغة ترد ويراد بها الخبر كما قلتم وترد والمراد بها غير الخبر كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فإذا ورد
مطلقا وجب التوقف فيه حتى يدل الدليل عليه كما قلنا في الأسماء
المشتركة كاللون والعين وغيرهما
والجواب هو أن هذا موضوع بإطلاقه للخبر ويستعمل في غيره بدليل كما قلنا في
البحر إنه موضوع بإطلاقه للماء الكثير المجتمع ويستعمل في الرجل الجواد
بدليل كذلك هاهنا
مسألة 2
يقع العلم بالأخبار المتواترةوقالت البراهمة لا يقع العلم بالأخبار المتواترة
لنا هو أن الإنسان يجد نفسه عالمة بما يسمع من أخبار البلدان النائية والأمم السالفة كما يجدها عالمة بما يحس بها من المحسوسات ومن أنكر ذلك كان بمنزلة من أنكر المشاهدات
واحتجوا أن كل واحد من العدد المتواتر يجوز عليه الصدق والكذب فإذا انضم بعضهم إلى بعض لم يتغير حاله في خبره فوجب أن لا يقع العلم بخبرهم
قلنا ليس إذا جاز ذلك على كل واحد منهم إذا انفرد جاز عليهم الاجتماع ألا ترى أن كل واحد من الجماعة إذا انفرد يجوز أن يعجز عن حمل الشيء الثقيل ثم لا يجوز أن يعجزوا عن ذلك عند الاجتماع
ولأنه عند الانفراد يجوز أن يدعو كل واحد منهم إلى الكذب فيكذب وعند الاجتماع لا يجوز أن تتفق دواعيهم على الكذب
قالوا ولأن كل واحد منهم عند الاجتماع يقدر على الكذب كما يقدر
عند الانفراد فإذا لم يقع العلم بخبرهم حال الانفراد لم يقع على الاجتماع
قلنا وإن كانوا قادرين على الكذب إلا أنه مع كثرتهم واختلاف هممهم لا
يتفقون على فعله كما أن كل واحد منهم يقدر على السرقة والزنا والقتل ولا
يتفقون على فعلها
قالوا ولأنه إذا جاز اتفاق الجماعة الكثيرة على الخطأ من حيث الاجتهاد وهم
أصحاب الطبائع والفلاسفة جاز اتفاقهم على الخطأ في خبرهم
قلنا ذاك يدرك بالاجتهاد فجاز أن يغلطوا فيه والخبر طريقه السماع
والمشاهدة فلا يجوز أن يتفق الخلق العظيم على الخطأ فيه
قالوا ولأنه لو كان العلم يقع بالأخبار لوجب أن يقع العلم بخبر اليهود عن
موسى عليه السلام والنصارى عن عيسى والمجوس عن إدريس والروافض عن أئمتها
قلنا من شرط التواتر أن يكون النقلة عددا لا يصح التواطؤ منهم على الكذب
وأن يستوي طرفاه ووسطه وهذه الشروط لم تتكامل فيما يروونه هؤلاء لأن
روايتهم ترجع إلى عدد يسير فلهذا لم يقع العلم بخبرهم
قالوا لو كان العلم يقع بالخبر المتواتر لوجب إذا تعارض خبران على التواتر
أن يقع به علمان متضادان وهذا محال
قلنا لا يتصور أن يتفق خبران في شيء واحد متضادان فسقط ما قالوه
مسألة 3
العلم الذي يقع بالخبر المتواتر ضرورةوقال البلخي من المعتزلة العلم الذي يقع به اكتساب وهو قول الدقاق
لنا هو أن ما يعلم الإنسان بذلك من أخبار البلاد النائية والأمم السالفة يعلمه علما لا يمكنه نفيه بالشك والشبهة فصار بمنزلة العلم الواقع بالحواس
ولأنه لو كان العلم يقع بها من جهة الاستدلال لوجب أن لا يقع بها
للصبيان لأنه لا يصح منهم النظر والاستدلال ولما وقع لهم العلم
بذلك دل على أن العلم بها يصح ضرورة
واحتجوا بأنه لو كان يقع العلم به ضرورة لاشترك الناس كلهم في إدراكه ولما
رأينا العقلاء ينكرون العلم به دل على أن العلم من جهته عن استدلال
قلنا نحن لا نعتد بخلاف من خالف في ذلك كما لا نعتد بخلاف من خالف في
المحسوسات من السوفسطائية
ثم لو جاز أن يجعل ذلك دليلا على نفي العلم به ضرورة لجاز أن يجعل خلاف من
خالف في المحسوسات دليلا على أن العلم لا يقع من جهة الحواس ضرورة ولما
بطل هذا بالإجماع بطل ما قالوه أيضا
قالوا ولأن الإنسان يسمع الشيء من الواحد والاثنين ولا يقع به العلم إلى
أن يتكاثروا فيبلغوا التواتر فيقع له حينئذ العلم فكان ذلك استدلالا
كالعلم الواقع بالنظر في العالم والاستدلال على حدثه
قلنا ليس إذا لم يقع العلم في ابتداء السماع لم يكن العلم الحاصل له عند
الانتهاء ضرورة ألا ترى أن الإنسان يرى الشيء من بعيد فلا يقع له العلم به
على التفصيل ثم يقرب منه فيعلم حقيقته على التفصيل ثم لا يقال إن ذلك
العلم استدلال
قالوا ولأن العلم لا يقع بأخبارهم إلا على صفات تصحبهم يستدل بها على
صدقهم فصار كالعلم بحدث العالم لما وقع عن الصفات التي تصحب العالم من
الاجتماع والافتراق كان اكتسابا فكذلك هاهنا
والجواب هو أن الأخبار وإن اعتبر فيها صفات إلا أن العلم بصدقهم لا يفتقر
إلى اعتبار الصفات ألا ترى أنه يجوز أن يقع العلم لمن لا ينظر في الصفات
ويخالف هذا العلم الواقع عن العالم فإن بذلك لا يقع إلا بعد النظر في
المعاني التي تصحب العالم والاستدلال بها فلذلك كان اكتسابا وفي الأخبار
يقع العلم من غير نظر واعتبار فافترقا
مسألة 4
ليس في التواتر عدد محصوروقال بعض الناس هم خمسة فصاعدا ليزيدوا على عدد الشهود وهو قول الجبائي
وقال بعضهم اثنا عشر بعدد النقباء
وقال بعضهم سبعون بعدد أصحاب موسى
وقال بعضهم ثلاثمائة وكسر بعدد أصحاب رسول الله يوم بدر
لنا هو أن التواتر ما وقع العلم الضروري بخبره وهذا لا يختص بعدد وإنما يوجد ذلك في جماعة لا يصح منها التواطؤ على الكذب فوجب أن يكون الاعتبار بذلك
ولأنه لو كان ذلك يقتضي عددا محصورا لاقتضى اعتبار صفتهم كما
قلنا في الشهادة ولما لم تعتبر صفات الرواة ولم تختلف باختلاف حالهم من
الكفر والإسلام والعدالة والفسوق دل على أنه لا اعتبار فيه بعدد محصور
وأما المخالفون فليس لهم شبهة يرجعون إليها إلا هذه الأعداد التي وردت في
المواضع التي ذكروها وهذا لا يصح لأنه لا ليس معهم أن هذه الأعداد اعتبرت
في المواضع التي ذكروها للتمييز بين ما يوجب العلم وبين مالا يوجب وإذا لم
يثبت هذا لم يتم الدليل
مسألة 5
لا يعتبر الإسلام في رواة التواتر ويقع العلم بتواتر الكفارومن أصحابنا من قال لا يقع العلم بتواتر الكفار
ومنهم من قال إن لم يطل الزمان وقع وإن طال الزمان وأمكن وقوع المراسلة والتواطؤ لم يقع
لنا أن العلم يقع للسامع بأخبارهم إذا وجدت على الشروط المعتبرة كما يقع بأخبار المسلمين فدل على أنه لا اعتبار بالإسلام
واحتجوا بأنه لما اختص المسلمون بالإجماع وجب أن يختصوا بالتواتر أيضا
والجواب هو أن هذا جمع من غير علة فلا يلزم على أن الإجماع إنما صار حجة بالشرع والشرع ورد في المسلمين دون الكفار وليس كذلك الأخبار فإنها توجب العلم من طريق العادة وما طريقه العادة لا يختلف فيه المسلمون والكفار
قالوا ولأنه لو كان يقع العلم بتواترهم لوقع لنا العلم بما أخبرت به النصارى من صلب عيسى عليه السلام ولما لم يقع لنا العلم بذلك دل على أن خبرهم لا يوجب العلم
قلنا إنما لم يقع هناك العلم لأن شرائط التواتر فيه لم تتكامل وهو استواء طرفي العدد ووسطه فإن النقل في الأصل يرجع إلى عدد يسير فلم يقع العلم بخبرهم وفي مسألتنا تكاملت شرائط الخبر من استواء طرفي العدد والوسط فوقع به العلم
مسألة 6
أخبار الآحاد لا توجب العلموقال بعض أهل الظاهر توجب العلم
وقال بعض أصحاب الحديث فيها ما يوجب العلم كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه
وقال النظام فيها ما يوجب العلم وهو ما قارنه سبب
لنا هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لأوجب خبر كل واحد ولو
كان كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة ومن يدعي مالا على غيره
ولما لم يقل هذا أحد دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم
ولأنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتبر فيه صفات المخبر من العدالة
والإسلام والبلوغ وغير ذلك كما لم يعتبر ذلك في أخبار التواتر
ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب أن يقع التبري بين العلماء فيما فيه خبر
واحد كما يقع التبري فيما فيه خبر متواتر
ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا ولما ثبت
أنه يقدم عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم
وأيضا هو أنه يجوز السهو والخطأ والكذب على الواحد فيما نقله فلا يجوز أن
يقع العلم بخبرهم
واحتج أهل الظاهر بأنه لو لم يوجب العلم لما وجب العمل به إذ لا يجوز
العمل بما لا يعلمه ولهذا قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم
والجواب هو أنه لا يمتنع أن يجب العمل بما لا يوجب العلم كما يقولون في
شهادة الشهود وخبر المفتى وترتيب الأدلة بعضها على بعض فإنه يجب العمل
بذلك كله وإن لم يوجب العلم
وأما قوله عز و جل ولا تقف ما ليس لك به علم فالجواب أن المراد
به ما ليس لك به علم من طريق القطع ولا من طريق الظاهر وما يخبر به الواحد
وإن لم يقطع به فهو معلوم من طريق الظاهر والعمل به عمل بالعلم
واحتج أصحاب الحديث بأن أصحاب هذه الأخبار على كثرتها لا يجوز أن تكون
كلها كذبا وإذا وجب أن يكون فيها صحيح وجب أن يكون ذلك ما اشتهر طريقه
وعرفت عدالة رواته
قلنا يبطل به إذا اختلف علماء العصر في حادثة على أقوال لا يحتمل غيرها
فإنا نعلم أنه لا يجوز أن تكون كلها باطلا ثم لا يمكن أن نقطع بصحة واحد
منها بعينه فبطل ما قالوه
واحتج النظام بأن خبر الواحد يوجب العلم وهو إذا أقر على نفسه بما يوجب
القتل والقطع فيقع العلم به لكل من سمع منه وكذلك إذا خرج الرجل من داره
مخرق الثياب وذكر أن أباه مات وقع العلم لكل من سمع ذلك منه فدل على أن
فيه ما يوجب العلم
والجواب هو أن لا نسلم أن العلم يقع بسماعه لأنه يجوز أن يظهر ذلك لغرض
وجهل يحمل عليه وقد شوهد من قتل نفسه بيده وصلب نفسه وأخبر بموت أبيه لغرض
يصل إليه وأمر يلتمسه فإذا احتمل ما ذكرناه لم يجز أن يقع العلم به
مسألة 7
يجوز التعبد بأخبار الآحادوقال بعض أهل البدع لا يجوز ذلك من جهة العقل
لنا هو أنه إذا جاز في العقل أن يعلق وجوب العبادات على شرائط إذا وجدت تعلق بها الوجوب جاز أن يعلق وجوب العبادة على ما يخبر به العدل ولا فرق بينهما
ولأنه إذا جاز أن يكون فرض الإنسان ما يخبر به المفتي ويشهد به الشاهد وان جاز عليهم السهو والخطأ ولم يقبح ذلك في العقل جاز أن يرد التعبد بالرجوع الى قوله في احكام الشرع
ولأن ما يفتى به المفتي اخبار عن دليل من أدلة الشرع وربما كان ذلك نصا وربما كان استنباطا فإذا جاز الرجوع إلى خبره مع الاحتمال الذي ذكرناه فلأن يجوز الرجوع إلى خبر من روى قول النبي عليه السلام أولى
ولأن الشرع قد ورد بالتعبد به ونحن ندل عليه ولو لم يجز ورود التعبد به لما ورد
واحتجوا بأن التكليف لا يجوز أن يتعلق إلا بما فيه المصلحة للمكلف
والمصلحة لا يعلمها إلا الله ورسوله صلى الله عليه و سلم وإذا
كان المخبر عنهما واحدا لم نعلم المصلحة لأنه يجوز عليه السهو والخطأ فوجب
أن لا يقبل
قلنا المصلحة تتعلق بما علق التكليف عليه وهو خبر العدل وإذا وجدنا ذلك
علمنا ما تعلق به المصلحة وإن لم نعلم حقيقة الحال فيما أخبر به وهذا كما
تقول في الحاكم إذا شهد عنده شاهدان بحق ثبت عنده عدالتهما جاز له أن يحكم
به وكان ذلك الحكم الذي أوجب الله تعالى وإن لم يعلم حال المشهود به في
الباطن
وجواب آخر وهو أنه لو كان هذا طريقا في رد الخبر لوجب أن يجعل ذلك طريقا
في رد الفتوى فيقال إن التعبد لا يتعلق إلا بما فيه مصلحة المكلف وذلك لا
يعلم بقول الواحد فيجب أن لا يقبل ولما لم يصح أن يقال هذا في الفتوى لم
يصح أن يقال ذلك في الأخبار
ولأنه لو كان خبر الواحد لا يجوز أن يتعلق به التكليف لجواز السهو والخطأ
على المخبر لوجب أن لا يجوز التعبد بطريق الاجتهاد وبناء دليل على دليل
وترتيب لفظ على لفظ لأن السهو والخطأ في ذلك كله يجوز وهذا لا يقوله أحد
فبطل ما قالوه
قالوا لو جاز التعبد بما يخبر به الواحد وإن لم يقع العلم بخبره لجاز أن
يقبل خبر الفاسق والمجنون
قلنا لو ورد التعبد بقبوله لقبلناه
ثم ليس إذا لم يقبل من الفاسق والمجنون لم يقبل ممن لا يقع العلم بخبره
كما تقول في الشهادة والفتوى لا تقبل من الفاسق والمجنون ثم تقبل ممن لا
يقع العلم بخبره
ولأن العقلاء يرجعون إلى من يوثق بخبره في أمورهم ولا يرجعون إلى من لا
يوثق به من المجانين والفساق فدل على الفرق بينهما
مسألة 8
يجب العمل بخبر الواحد من جهة الشرعومن أصحابنا من قال يجب العمل به من جهة العقل والشرع
وقال القاساني لا يجب العمل به وهو قول ابن داود والرافضة
لنا قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فأوجب الحذر مما تنذر
به الطائفة
فإن قيل وجوب الإنذار لا يدل على وجوب الرجوع إلى قول المنذر وحده بل يجوز
أن يفتقر الرجوع إلى آخر كما يجب على الشاهد أن يشهد بما عنده ثم لا يجب
العمل بقوله حتى يشهد معه غيره
قيل قد أوجب الإنذار وأوجب الحذر من المخالفة وهذا يقتضي وجوب الحذر بمجرد
الإنذار
فإن قيل الحذر هو أن ينظر ويعمل بما يقتضيه الدليل لا أن يعمل بما أخبر به
قيل إذا تعلق الوعيد بترك أمر فالحذر عن مخالفته هو أن يفعل ذلك الشيء
فأما إذا لم يفعل فلم يحذر فلم يكن ممتثلا لما اقتضاه الظاهر
وأيضا قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فدل على أنه إذا جاءه عدل لم
يتبين في خبره
وأيضا فإن النبي عليه السلام كان بعث أصحابه إلى البلدان أمراء وعمالا
وقضاة واحدا واحدا ولو لم يجز العمل بخبر كل واحد منهم لما بعثهم آحادا
فإن قيل يجوز أن يكون قد بعثهم إلى قوم في أحكام علموها بالتواتر قبل بعثة
الرسول كما علموا في قولكم وجوب العمل بخبر الواحد قبل بعث الرسل
قيل لو كان نقل إليهم في ذلك تواتر لنقل إلينا وعلمناه كما علمنا كل ما
تواتر به الخبر وأما وجوب العمل بخبر الواحد فقد علموه بما تواتر به الخبر
من بعثة الرسل إلى كل جهة
فإن قيل فقد كان أيضا يبعث ويدعو إلى الإيمان وإن لم يكن معلوما
من جهة الرسل فكذلك في الأحكام
قيل عندنا لم يعلم وجوب الإيمان إلا من جهة الشرع وعندهم يعلم ذلك بالعقل
فبعث من ينبههم على أعمال الفكر والنظر في الدليل ويدل عليه إجماع الصحابة
رضي الله عنهم فإنهم عملوا بأخبار الواحد في مسائل مختلفة وأحكام شتى
روى أن أبا بكر رضي الله عنه عمل بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في ميراث
الجدة
وعمل عمر رضي الله عنه بخبر عبد الرحمن في أخذ الجزية من المجوس وبخبر حمل
بن مالك في دية الجنين وقالوا لولا هذا لقضينا بغيره
وبحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها
وعمل عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة بنت مالك في سكنى المتوفى عنها زوجها
وعن علي كرم الله وجهه أنه قال كان إذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله
عليه و سلم بشيء أحلفته فإن حلف صدقته إلا أن أبا بكر رضي الله عنه فإنه
حدثني وصدق أبو بكر
وعمل ابن عمر في ترك المخابرة بحديث رافع بن خديج
وعمل ابن عباس رضي الله عنه بحديث أبي سعيد الخدري في الربا في النقد
وعمل زيد بن ثابت رضي الله عنه بخبر امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر بغير
وداع
وعلموا كلهم بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه إن الأئمة من
قريش وبحديث عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين فدل على وجوب العمل
به
فإن قيل هذه أخبار آحاد فلا يحتج بها في إثبات خبر الواحد
قيل هذا تواتر من طريق المعنى فإنها وإن وردت في قصص مختلفة فهي متفقة على
إثبات خبر الواحد فصار ذلك كالأخبار المتواترة في سخاء حاتم وشجاعة علي
كرم الله وجهه
فإن قيل يجوز أن يكون قد علموا بذلك لأسباب اقترنت بها
قيل لم ينقل غير الأخبار والرجوع إليها فمن ادعى زيادة على ذلك احتاج إلى
دليل
ولأنه لو كان هناك سبب آخر يوجب العمل به لنقل ولم يخل به
فإن قيل إنما رجعوا إلى تلك الأخبار لأنها نقلت بحضرة الصحابة رضي الله
عنهم ولم ينكر على رواتها فصار ذلك إجماعا منهم على قبولها فوجب المصير
إليها لأجل الإجماع
قيل لو كانت تلك الأخبار عند جماعتهم لما أشكلت عليهم الأحكام قبل روايتها
فإن قيل إن كان قد نقل عنهم العمل بخبر الواحد فقد نقل عنهم أيضا الرد
لخبر الواحد
ألا ترى أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل خبر المغيرة حتى شهد
معه محمد بن مسلمة
ورد عمر رضي الله عنه خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد معه أبو
سعيد الخدري
ورد علي عليه السلام حديث أبي سنان في المفوضة
قيل قبولهم على ما بيناه دليل على وجوب العمل به وردهم لا يدل على أنه لا
يجوز العمل به لأنه يجوز الرد إذا وجد علة تقتضي الرد
ألا ترى أن الخبر المتواتر يجب العمل به بالإجماع ثم رددنا تواتر النصارى
أن المسيح صلب ولا يمنع ذلك العمل بالمتواتر لا سيما وقد روى في بعض
المواضع التي ذكروها العلة التي اقتضت الرد والتوقف فروي عن عمر أنه قال
في الاستئذان لأبي موسى فعلت ذلك لكي لا يجترأ على رسول الله صلى الله
عليه و سلم
وقال علي عليه السلام في خبر أبي سنان أعرابي بوال على عقبيه أي لا يعرف
الأحكام فلا يعول على روايته
ويدل عليه هو أنه إخبار عن حكم شرعي فوجب قبول خبر الواحد فيه
كالفتوى
ولأنه لو لم يجب العمل بخبر الواحد لوجب أن يكون ما بين النبي عليه السلام
طول عمره يختص به من سمع ذلك منه لا يلزم غيره اعتقاده والعمل به لأنه لم
ينقل إلى غيره نقل تواتر وهذا لا يقوله أحد
واحتجوا بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وما أخبر به الواحد لا علم
له به فيجب أن لا يقفو
قلنا إن كان العمل بخبر الواحد عملا بما لا علم له به فرده أيضا عمل بما
لا علم له به فيجب أن لا يرد وعلى أن العمل بخبر الواحد عندنا عمل لما
يعلمه لأن الذي دل على وجوب العمل به موجب للعلم قاطع للعذر وإن كان ما
يخبر به يجوز فيه الصدق والكذب وهذا كما تقول في الرجوع إلى قول الشاهد
وقول المفتي إنه رجوع إلى العلم والعمل به وإن كان ما يشهد به الشاهد
ويفتى به المفتي يجوز أن يكون صحيحا ويجوز أن يكون باطلا
قالوا ولأنه لو جاز أن يقبل من غير دليل لوجب أن يقبل قول من ادعى النبوة
من غير دليل
قلنا نعارضكم بمثله فنقول ولو جاز رد خبر الواحد من غير دليل لجاز رد قول
النبي عليه السلام من غير دليل
ولأنه إذا جاز أن يقبل قول المفتي وخبر الشاهد من غير حجة وإن لم تقبل
دعوى النبوة من غير حجة جاز أيضا أن يقبل خبر الواحد وإن لم تقبل دعوى
النبوة من غير حجة
وعلى أن خبر الواحد لا يقبل إلا بدليل وهو ما دللنا به على وجوب العمل به
من الكتاب والسنة والإجماع ويخالف دعوى النبوة فإن هناك لو نعلم نبوته إلا
من جهته ولم يقم دليل على صحته فلم يثبت وهاهنا الشرع قد ثبت قبله وعلم من
جهته قبوله فوجب المصير إليه
قالوا ولأنه لو جاز قبول خبر الواحد في فروع الدين لجاز قبوله
في الأصول من التوحيد وإثبات الصفات
قلنا في مسائل الأصول أدلة توجب القطع من طريق العقل فلا يعدل عنها إلى
خبر الواحد كما أن من عاين القبلة لا يرجع إلى الاجتهاد في طلبها وليس
كذلك الفروع فإنه ليس فيها طريق يوجب القطع فجاز الرجوع فيها إلى الظن كما
نقول في الغائب عن القبلة
قالوا ولأن براءة الذمة متيقنة وخبر الواحد موضع شك فلا يجوز إزالة اليقين
بالشك
قلنا نحن لا نزيل اليقين إلا بيقين مثله ووجوب العمل بخبر الواحد يقين وإن
كان ما تضمنه غير متيقن
ولأنه لو كان هذا صحيحا في رد الخبر لوجب أن يجعل طريقا في إبطال الشهادة
والفتاوى فيقال براءة الذمة متيقنة والشهادة والفتوى موضع شك وشبهة فلا
يترك اليقين بالشك
وعلى أن حكم الأصل غير متيقن بعد ورود الخبر بل هو حال شك وشبهة لأنا نجوز
أن يكون الأمر قد تغير عما كان عليه في الأصل فلا يكون العمل بالخبر إزالة
يقين بالشك
قالوا ولأن المخبر كالمفتي ثم ثبت أن ما يفتي به المفتي لا يلزم العالم
العمل به حتى يعلم صحته فكذلك ما يخبر المخبر يجب أن لا يلزم العمل به حتى
تعلم صحته
قلنا إن كان لا يجوز للعالم أن يعمل بفتواه قبل العلم بصحته فيجوز للعامي
أن يعمل به قبل العلم بصحته فليس لهم أن يتعلقوا بأحد الفريقين إلا ولنا
أن نتعلق بالفريق الآخر
ولأن العالم لا مشقة عليه في معرفة ما أفتى به لأن له اجتهادا يرجع إليه
وليس كذلك هاهنا فإنا لو ألزمنا الناس أن يعرفوا ما سمعوه من
الأخبار من طريق التواتر لشق على الناس فصار بمنزلتهم في ذلك من الفتوى
منزلة العامي لما شق عليهم الانقطاع إلى الفقه جوز لهم التقليد في الفتوى
وإن لم يعلموا صحة ما أفتوا به
قالوا ولأنه لو كان العمل بخبر الواحد واجبا لوجب التوقف عنه وعن سائر
أدلة الشرع لأنه إذا أراد العمل بخبر الواحد جوز أن يكون هناك ما هو أولى
من أخبار الآحاد فيحتاج أن يتوقف عن العمل به حتى يحيط علمه بجميع ما روى
عن النبي صلى الله عليه و سلم وهذا لا سبيل إليه فوجب أن يكون العمل به
باطلا
قلنا لو كان تجويز ما هو أولى منه من الأدلة يجوز أن يمنع العمل بما وقع
إليه منها لوجب أن لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهد ولا للعامي أن يعمل
بفتوى فقيه لجواز أن يكون هناك ما هو أولى منه ولما بطل هذا بطل ما ذكروه
ولأنه لو جاز أن يكون هذا طريقا للمنع من الأخبار لوجب أن يجعل طريقا إلى
المنع من العمل بالاجتهاد لأنه متى رتب دليلا على دليل باجتهاده جوز أن
يكون هناك ما هو أولى منه فيؤدي إلى إبطاله ولما لم يجز أن يقال هذا في
إبطال الاجتهاد لم يجز أن يقال في إبطال الأخبار
مسألة 9
يجب العمل بخبر الواحد وإن انفرد الواحد بروايتهوقال أبو علي الجبائي لا يجوز حتى يرويه اثنان عن اثنين إلى النبي صلى الله عليه و سلم
وقال بعض الناس لا يقبل أقل من أربعة
لنا قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فدل على أنهم إذا جاءهم عدل لم يتبينوا
وأيضا هو أن النبي عليه السلام كان يبعث عماله وقضاته إلى البلاد آحادا فبعث معاذا إلى اليمن وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة وبعث مصعب بن عمير إلى المدينة وبعث عمر وأبي بن كعب وأبا هريرة على الصدقات واحدا واحدا
وأيضا فإن الصحابة رجعت في التقاء الختانين إلى حديث عائشة رضي
الله عنها وحدها
ولأنه خبر عن حكم شرعي فلم يعتبر فيه العدد كالفتوى ولأن مالا يشترط في
الفتوى لا يشترط في قبول الخبر كالحرية والذكورة
ولأنه خبر لا تشترط فيه الحرية فلا يعتبر فيه لاعدد كالخبر في الأذن في
دخول الدار وقبول الهدية
ولأنه طريق لإثبات الحكم فلا يشترط فيه العدد دليله الأصول التي يقاس
عليها
ولأنا لو اعتبرنا رواية اثنين عن اثنين إلى أن يتصل بالنبي صلى الله عليه
و سلم لشق ذلك فوجب أني سقط اعتباره
واحتجوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يعمل بخبر المغيرة في ميراث
الجدة حتى شهد عنده محمد بن مسلمة وعمر لم يعمل بخبر أبي موسى في
الاستئذان حتى شهد معه أبو سعيد الخدري فدل على أنه لا بد من العدد
والجواب هو أنه يجوز أن يكونا طلبا الزيادة احتياطا ولهذا روي عن عمر رضي
الله عنه أنه قال لأبي موسى الأشعري لا أتهمك ولكني أردت أن لا يجترىء أحد
على رسول الله صلى الله عليه و سلم
والذي يدل عليه أنا روينا عن عمر رضي الله عنه الرجوع إلى خبر الواحد فدل
على أن التوقف كان لما ذكرناه
قالوا ولأنه خبر شرط فيه العدالة فاعتبر فيه العدد أصله الشهادات
قلنا هذا يبطل بالفتوى فإنه يعتبر فيه العدالة ولا يعتبر فيه العدد
على أنه لو كان بمنزلة الشهادات لوجب أن لا يقبل من العبيد والنساء في
الحدود ولوجب أن يختلف عدده باختلاف الأحكام كما اختلفت الشهادات باختلاف
الحقوق ولما قبل ذلك من العبيد والنساء ولم يختلف باختلاف الأحكام دل على
أنه بمنزلة الفتوى
مسألة 10
يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوىوقال أصحاب أبي حنيفة لا يقبل
لنا هو أن الصحابة رضي الله عنهم رجعت إلى حديث عائشة في التقاء الختانين وهو مما تعم به البلوى
وقال ابن عمر كنا نخاير أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسا حتى أتانا رافع ابن خديج فأخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك فتركناه لقول رافع
ولأنه حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد فجاز إثباته بخبر الواحد
دليله ما لا تعم به البلوى
ولأنه كل دليل ثبت به ما لا تعم به البلوى ثبت به ما تعم به البلوى كالسنة المتواترة
ولأن كل حكم ثبت بالقياس ثبت بخبر الواحد
دليله ما لا تعم به البلوى
ولأن القياس فرع مستنبط من خبر الواحد فإذا جاز إثبات ما تعم به
البلوى بالقياس فلأن يجوز بخبر الواحد الذي هو أصله أولى
ولأن وجوب العمل بخبر الواحد ثبت بدليل قاطع وهو إجماع الصحابة فصار
كالقرآن المقطوع بصحته فإذا جاز إثبات ما تعم به البلوى بالقرآن جاز
إثباته أيضا خبر الواحد
واحتجوا بأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه وإذا كثر السؤال عنه كثر
الجواب وإذا كثر الجواب كثر النقل فلما رأينا النقل قد قل دل على أنه لا
أصل له ولهذا المعنى رددنا حديث الرافضة في النص على إمامة علي عليه
السلام وقلنا أنه لو كان صحيحا لكثر النقل فيه
والجواب هو أنا لا نسلم أنه إذا كثر الجواب كثر النقل بل يجوز أن يكثر
الجواب ولا يكثر النقل وذلك أن نقل الأخبار على حسب الدواعي ولهذا حج
النبي عليه السلام في الجم الغفير والعدد الكثير وبين المناسك بيانا عاما
ثم لم يروه إلا نفر منهم ولهذا كان كثير من الصحابة لا يؤثرون رواية
الأخبار فإذا كان كذلك جاز أن يكثر الجواب ولا يكثر النقل
ويخالف هذا ما ذكروه من جهة الإمامة فإن ذلك عندهم يجب على كل أحد أن
يعلمه ويقطع به فلا يجوز أن يثبت بنقل خاص وليس كذلك هاهنا فإنه من مسائل
الاجتهاد ويجوز أن ينفرد به البعض بعلمه ويكون فرض الباقين الاجتهاد أو
التقليد فافترقا
مسألة 11
يقبل خبر الواحد وإن كان مخالفا للقياس ويقدم عليهوقال أصحاب مالك إذا كان مخالفا للقياس لم يقدم
وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان مخالفا لقياس الأصول لم يقبل
لنا ما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ بم تحكم قال
بكتاب الله تعالى قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو فقال النبي عليه السلام الحمد لله
الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم لما يحبه ويرضاه رسول الله
فرتب العمل بالقياس على السنة فدل على أن السنة مقدمة
ويدل عليه أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في الجنين لحديث حمل بن مالك بن
النابغة وقال لولا هذا لقضينا بغيره
وروي أنه كان يقسم ديات الأصابع على قدر منافعها ثم ترك ذلك بقوله عليه
السلام في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل ولم ينكر عليه أحد
ولأن القياس يدل على قصد صاحب الشرع من طريق الظن والخبر يدل على قصده من
طريق الصريح فكان الرجوع إلى الصريح أولى
ولأن الاجتهاد في الخبر في عدالة الراوي فقط وفي القياس علة الأصل ثم في
إلحاق الفرع به لأن من الناس من منع إلحاق الفرع به إلا بدليل آخر فكان
المصير في ما قل فيه من جهة الاجتهاد أولى لأنه أسلم من الغرر
وأيضا هو أنه لو سمع القياس والنص المخالف له من رسول الله صلى الله عليه
و سلم لقدم النص فيما يتناوله على القياس فلأن يقدم على قياس لم يسمع من
رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى
ولأن النص ينقض به حكم الحاكم فيما فيه خلاف والقياس لا ينقض به فدل على
أن النص أقوى فلا يجوز تركه لما هو دونه
وأما أصحاب أبي حنيفة فيقال لهم ما الذي تريدون بمخالفة الأصول فإن قالوا
نريد به معاني الأصول فهو كقول أصحاب مالك وقد بينا فساده
ولأنهم ناقضوا في هذا فإنهم يتركون القياس بخبر الواحد ويسمونه موضع
الاستحسان ولهذا قال أبو حنيفة القياس أن من أكل ناسيا بطل صومه إلا أني
أتركه لحديث أبي هريرة
وقالوا القياس أنه لا يجوز التوضؤ بنبيذ التمر ولكنا تركناه لحديث ابن
مسعود وأمثال ذلك على أصلهم كثير
وإن أرادوا بالأصول الكتاب والسنة والإجماع وافقناهم عليه إلا
أنهم يذكرون ذلك في مواضع لا كتاب فيها ولا سنة ولا إجماع وهو في خبر
المصراة والتفليس والقرعة فبطل ما قالوه 1 واحتج أصحاب مالك بأن القياس
يتعلق باستدلاله والخبر رجوع إلى قول الغير وهذا بفعله أوثق منه بفعل غيره
فكان الرجوع إليه أولى ولهذا قدمنا اجتهاده على اجتهاد غيره من العلماء
قلنا لا فرق بينهما لأنه يرجع في عدالة الراوي ومعرفة صدقه إلى أفعاله
التي قد شاهدها منه كما يرجع إلى المعنى الذي أودعه صاحب الشريعة في الأصل
فيحكم به في الفرع بل طريق معرفة العدالة أظهر لأنه رجوع إلى العيان
والمشاهدة وطريق معرفة العلة الفكر والنظر فكان الرجوع إلى الخبر أولى
قالوا ولأن الأصول وإن اتفقت على إيجاب حكم لم تحتمل إلا وجها واحدا وخبر
الواحد يحتمل السهو على رواته فلا يجوز ترك مالا يحتمل بما هو محتمل كنص
القرآن بالسنة إذا تعارضا
قلنا إنما يجوز ترجيح أحد الأمرين على الآخر بنفي الاحتمال إذا ثبت أنهما
دليلان وفي مسألتنا القياس ليس بدليل إذا عارضه النص فلا يجوز أن يرجع على
النص بنفي الاحتمال
على أن هذا يبطل بنص السنة إذا عارضه مقتضى العقل في براءة الذمة فإن
براءة الذمة في العقل لا تحتمل إلا وجها واحدا ونص السنة يحتمل السهو على
رواته ثم يقدم على مقتضى العقل الذي لا احتمال فيه
قالوا إذا اتفقت الأصول على شيء واحد دلت على صحة العلة قطعا ويقينا فلو
قبلنا خبر الواحد في مخالفته لنقضنا العلة وصاحب الشرع لا يتناقض في علله
فيجب أن يحمل الخبر على أن الراوي سها فيه ولهذا رددنا ما خالف أدلة
العقول من الأخبار المروية في السنة لما أوجب نقض أدلة قاطعة
قلنا لا نسلم أنه إذا خالف النص كان ذلك علة لصاحب الشرع حتى لا
يجوز أن يتناقض فيه فيجب أن يثبتوا علة حتى يصح هذا الدليل
ثم يبطل به إذا عارضه نص كتاب أو خبر متواتر فإنه يؤدي إلى نقض علة صاحب
الشرع على زعمهم ثم يقبل ويقدم على القياس
وعلى أنه متى خالف النص زدنا فيه وصفا آخر فمنع من دخول النقض ويخالف هذا
إذا ورد النص مخالفا لأدلة العقل فإنه لا يمكن الزيادة في أدلة العقل
وهاهنا يمكن فافترقا
ولأن الشرع لا يجوز أن يرد بما يخالف أدلة العقول فعلمنا أنه خطأ من
الراوي وليس كذلك هاهنا فإنه يجوز أن يرد النص بما يخالف القياس فافترقا
إذا روى الخبر اثنان وتفرد أحدهما بزيادة قبلت الزيادة
وقال بعض أصحاب الحديث لا تقبل الزيادة أصلا
لنا هو أن هذه الزيادة لا تنافي المزيد عليه فهو كما لو انفرد أحدهما
بزيادة حديث لا يرويه الآخر
ولأنه يجوز أن يكون أحدهما سمع الحديث من أوله إلى آخره والآخر سمع بعضه
أو أحدهما ذكر الحديث كله والآخر نسي بعضه فلا يجوز رد الزيادة بالشك
ولأن الخبر كالشهادة ثم في الشهادة لو شهد شاهدان على رجل أنه أقر بألف
وشهد آخران أنه أقر بألف وخمسمائة فإنه تثبت الزيادة فكذلك في الخبر
ولأنه لو كان ما انفرد به أحدهما مما لا يقبل لوجب أن لا يقبل ما انفرد به
أبي وابن مسعود في القراءات لأنها روايات انفردوا بها عن الصحابة
واحتجوا بأنهما مشتركان في السماع فلو كانت الزيادة صحيحة لاشتركا فيها
قلنا تبطل بما ذكرناه من الشهود على أنا بينا أنه يجوز سماع البعض دون
البعض ويجوز أن يشتركا في الجميع وينسى أحدهما بعضه وإذا احتمل هذا لم يجز
رد الزيادة
قالوا ولأن في التقويم يقدم قول من قوم بالنقصان فكذلك في الخبر
قلنا هذا مخالف للتقويم فإن شهادة المقوم معارضة في الزيادة ألا ترى أن من
قوم بالنقصان يذكر أنه عرف السلعة وسعر السوق ولا تساوي إلا
كذا ومن قوم بالزيادة يذكر أنه عرف السلعة وسعر السوق وهو يساوي
كذا وليس كذلك في الخبر فإن من روى الخبر ناقصا لا يمنع الزيادة فلا يقدح
في صحتها فوجب الأخذ بها
قالوا ما اتفقنا عليه من الخبر يقين والزيادة مشكوك فيها فلا يترك اليقين
بالشك
قلنا فيجب إذا انفرد أحدهما بخبر لم يروه الآخر أن لا يقبل فيقال أحد
الخبرين يقين والآخر مشكوك فيه فلا يترك اليقين بالشك
على أنا لا نقول إن الزيادة مشكوك فيها بل هي ثابتة على مقتضى الظاهر لأنه
ثقة فلو لم يسمع لما ذكر والأخذ بالظاهر من الأخبار واجب
قالوا إذا انفرد واحد من الجماعة بزيادة فقد خالف إجماع أهل العصر فهو
كالواحد إذا خالف الإجماع
قلنا المعنى هناك أن أهل الاجتهاد أجمعوا على خطئه فوزانه من مسألتنا أن
يجمع أهل الاجتهاد على إبطال الزيادة فتسقط وأما هاهنا فإنهم لم يقطعوا
بإبطال الزيادة فوجب الأخذ بها
قالوا لو كان لهذه الزيادة أصل لما خص رسول الله صلى الله عليه و سلم
بعضهم بها لأن في ذلك ترعيضا للباقين للخطأ
قلنا لا نقول إنه خص بعضهم بالزيادة بل حدث الجميع بالحديث كله ولكن نسي
بعضهم بعض الحديث أولم يحضر بعضهم من أول الحديث إلى آخره
وعلى أنه يجوز أن لا يحدث بعضهم بجميع الحديث على التفصيل إذا لم تدع
الحاجة إلى البيان وإنما لا يجوز ذلك عند الحاجة فسقط ما قالوه
قالوا ولأنه قد جرت عادة الرواة بتفسير الأحاديث وإدراج ذلك في جملة الخبر
فلا يؤمن أن تكون هذه الزيادة من هذا الجنس فيجب أن لا تقبل