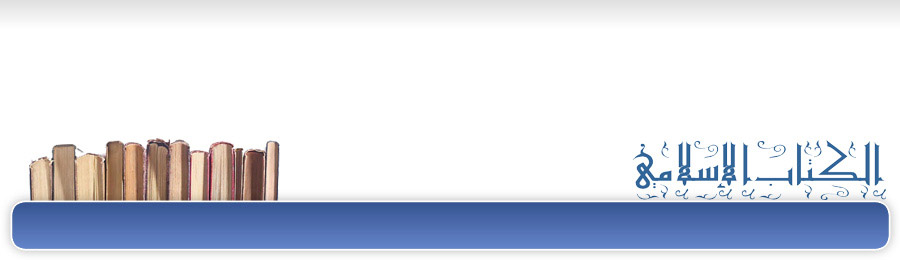كتاب : الهوامل والشوامل
المؤلف : التوحيدي
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة الأولى وهي لغوية
قلت أعزك الله: ما الفرق بين العجلة والسرعة؟ وهل يجب أن يكون بين كل لفظتين - إذا تواقعتا على معنى، وتعاورتا غرضاً - فرق، لأنك تقول: سر فلان وفرج، وأشر فلان ومرح، وبعد فلان ونزح، وهزل فلان ومزح، وحجب فلان وصد، ومنع فلان ورد، وأعطى فلان وناول، ورام فلان وحاول، وعالج فلان وزاول، وذهب فلان ومضى، وحكم فلان وقضى، وجاء فلان وأتى، واقترب فلان ودنا، وتكلم فلان ونطق، وأصاب فلان وصدق، وجلس فلان وقعد، ونأى فلان وبعد، وحضر فلان وشهد، ورغب عن كذا وزهد.وهل يشتمل السرور والحبور، والبهجة والغبطة، والفكه، والجذل والفرح، والإرتياح، والبجح على معنى واحد أو على معان مختلفة؟ وخذ على هذا؛ فإن بابه طويل، وحبله مثنى وشكله كثير.
فإن كان بين كل نظيرين من ذلك يفصل معنى من معنى ويفر مراداً من مراد، ويبين غرضاً من غرض، فلم لا يشترك في معرفته، كما اشترك في معرفة أصله؟.
وعلى هذا فما الفرق بين الغرض والمعنى والمراد، وها هو ذا وقد تقدم آنفاً؟.
وما الذي أوضح الفرق بين نطق وسكت، وألبس الفرق بين نطق وتكلم، وبين سكت وصمت؟.
الجواب: قال أبو علي أحمد بن محمد مسكويه: لما كنا نحتاج في الجواب عن هذه المسألة إلى ذكر السبب الذي من أجله احتيج إلى الكلام المصطلح عليه، والحاجة الباعثة على وضع الأسماء الدالة بالتواطؤ، والعلة الداعية إلى تأليف الحروف التي تصير أسماء وأفعالاً وحروفاً بالإتفاق والاصطلاح، والأقسام التي تعرض لنا بموجب حكم العقل - قدمنا بيان ذلك أمام الجواب؛ ليكون توطئة له، وليسهل علينا هذا المطلب، ويبين عن نفسه، ويعين على ما اعتاض منه، فأقول: إن السبب الذي احتيج من أجله إلى الكلام هو أن الإنسان الواحد لما كان غير مكتف بنفسه في حياته، ولا بالغ حاجاته في تتمة بقائه مدته المعلومة، وزمانه المقدر المقسوم - احتاج إلى استدعاء ضروراته في مادة بقائه من غيره، ووجب بشريطة العدل أن يعطى غيره عوض ما استدعاه منه، بالمعاونة التي من أجلها قال الحكماء: إن الإنسان مدنى بالطبع.
وهذه المعاونات والضرورات المقتسمة بين الناس، التي بها يصح بقاؤهم، وتتم حياتهم، وتحسن معايشهم، هي أشخاص وأعيان من أمور مختلفة، وأحوال غير متفقة، وهي كثيرة غير متناهية، وربما كانت حاضرة فصحت الإشارة إليها، وربما كانت غائبة فلم تكف الإشارة فيها، فلم يكن بد من أن يفزع إلى حركات بأصوات دالة على هذه المعاني بالاصطلاح، ليستدعيها بعض الناس من بعض، وليعاون بعضهم بعضاً، فيتم لهم البقاء الإنساني، وتكمل فيهم الحياة البشرية.
وكان الباري - جل وعز - بلطيف حكمته، وسابق علمه وقدرته، قد أعد للإنسان آلة هي أكثر الأعضاء حركة، وأوسعها قدرة على التصرف، ووضعها في طريق الصوت وضعاً موافقاً لتقطيع ما لا يخرج منه مع النفس، ملائماً لسائر الأخر المعينة في تمام الكلام - كانت هذه الآلة أجدر الأعضاء باستعمال أنواع الحركات المظهرة لأجناس الأصوات الدالة على المعاني التي ذكرناها وقد بلغت عدة هذه الأصوات المفردة المقطعة بهذه الحركات المسماة حروفاً - ثمانية وعشرين حرفاً في اللغة العربية.
ثم ركبت كلها ثنائياً وثلاثياً ورباعياً، وجميعها متناهية محصاة؛ لأن أصولها وبسائطها محصورة معدودة، فالمركبات منها أيضاً محصورة معدودة.
ولما كانت قسمة العقل توجب في هذه الكلم إذا نظر إليها بحسب دلالتها على المعاني أن تكون على أحوال خمس لا أقل منها ولا أكثر وجدت منقسمة إليها لا غير، وهي: أن يتفق اللفظ والمعنى معاً، أو يختلفا معاً، أو تتفق الألفاظ وتختلف المعاني، أو تختلف الألفاظ وتتفق المعاني، أو تتركب اللفظة فيتفق بعض حروفها وبعض المعنى وتختلف في الباقي.
وهذه الألفاظ الخمسة هي التي عدها الحكيم في أول كتبه المنطقية، وتكلم عليها المفسرين وسموها المتفقة، والمتباينة، والمتواطئة، والمترادفة، والمشتقة، وهي مشروحة هناك، ولكن السبب الذي من أجله احتيج إلى وضع الكلام يقتضى قسماً واحداً منها، وهو أن تختلف الألفاظ بحسب اختلاف المعاني، وهي المسماة المتباينة، فأما الأقسام الباقية فإن ضرورات دعت إليها، وحاجات بعثت عليها ولم تقع بالقصد الأول، وسنشرح ذلك بعون الله وتوفيقه.
وقد تقدم البيان أن المعاني والأحوال التي تتصور للنفس كثيرة
جداً، وأنها بلا نهاية.
فأما الحروف الموضوعة الدالة بالتواطؤ، والمركبات منها، فمتناهية محصورة
محصاة بالعدد.
ومن الأحكام البينة والقضايا الواضحة ببدائه العقول، أن الكثير إذا قسم
على القليل اشتركت عدة منها في واحدة لا محالة، فمن ههنا حدث الاتفاق في
الإسم، وهو أن توجد لفظة واحدة دالة على معان كثيرة، كلفظة العين الدالة
على العين التي يبصر بها، وعلى عين الماء، وعين الركبة، وعين الميزان،
والمطر الذي لا يقلع أياماً، وأشباهه من الأسماء كثيرة جداً ولم يقع هذا
الفعل المؤدي إلى الإلباس والإشكال، وإلى الغلط والخطأ في الأعمال
والإعتقادات باختيار، بل باضطرار طبيعي كما بينا وأوضحنا.
وعرض بعد ذلك أن أصحاب صناعة البلاغة، وصناعة الشعر والسجع، وأصحاب
البلاغة والخطابة هم الذين يحتاجون إلى الإقناعات العامية في مواقف
الإصلاح بين العشائر مرة، والحض على الحروب مرة، والكف عنها مرة، وفي
المقامات الأخر التي يحتاج فيها إلى الإطالة والإسهاب، وترديد المعنى
الواحد على مسامع الحاضرين؛ ليتمكن من النفوس، وينطبع في الأفهام - لم
يستحسنوا إعادة اللفظة الواحدة مراراً كثيرة، ولا سيما الشاعر؛ فإنه مع
ذلك دائم الحاجة إلى لفظ يضعه مكان لفظ دال على معناه بعينه؛ ليصحح به وزن
شعره، ويعدل به أقسام كلامه.
فاحتيج لأجل ذلك إلى أسماء كثيرة دالة على معنى واحد.
وهذا العارض الذي عرض للألفاظ المترادفة كأنه مناصب للقصد الأول في وضع
الكلام، مخالف له، وقد دعت الحاجة إليه كما تراه، ولولا حاجة الخطباء
والشعراء، وأصحاب السجع والموازنة إليه لكان لغواً باطلاً.
ولما كانت المسألة متعلقة بهذين القسمين من الكلام اقتصرنا على شرحهما،
وعولنا - بمن نشط للوقوف على الأقسام الأخر - على الكتب المصنفة فيها لأهل
المنطق؛ لأنها مستقصاة هناك.
وإذ قد فرغنا من التوطئة التي رمناها أمام المسألة، فإنا نأخذ في الجواب
عنها فنقول: إن من الألفاظ ما توجد متباينة، وهي التي تختلف باختلاف
المعنى، وإليها كان القصد الأول بوضع اللغة.
ومنها ما توجد متفقة، وهي التي تتفق فيها ألفاظ واحدة بعينها ومعانيها
مختلفة.
ومنها ما توجد مترادفة، وهي التي تختلف ألفاظها ومعانيها واحدة.
وهذان القسمان حدثا بالضرورة كما بينا.
وربما وجدت ألفاظ مختلفة دالة على معان متقاربة، وإن كانت أشخاص تلك
المعاني مختلفة، وربما دلت على أحوال مختلفة ولكنها مع اختلافها هي لشخص
واحد، فلأجل ذلك يستعملها الخطيب والشاعر مكان المترادفة، لموضع المناسبة
والشركة القريبة بينها، وإن كانت متباينة بالحقيقة، ومثال ذلك ما يوجد من
أسماء الداهية، فإنها على كثرتها نعوت مختلفة، ولكنها لما كانت لشيء واحد
استعملت كأنها معنى واحد.
وكذلك أسماء الخمر، والسيف، وأشباهها.
وأنت إذا أنعمت النظر، واستقصيت الروية وجدت هذه الأشياء مختلفة المعاني،
ولكنها لما كانت أوصافاً لموصوف واحد أجريت مجرى الأسماء الدالة على معنى
واحد، وذلك عند اتساع الناس في الكلام، وعند حاجتهم إلى التسمح وترك
التكلف والتجوز في كثير من الحقائق.
ولولا علمي بثقافة فطنتك، وإحاطة معرفتك، وسرعة تطلعك بفهمك على ما أومأت
إليه لتكلفت لك الفرق بين معاني ألفاظ الخمر والشراب والشمول والراح
والقهوة، وسائر أسمائها، وبين معاني ألفاظ السيف والصمصام والحسام وباقي
ألقابه ونعوته، وكذلك في أسماء الدواهي ونعوتها، ولكني رأيت تجشم ذلك
فضلاً وإطالة عليك بما لا فائدة لك فيه.
فينبغي لنا إذا وجدنا ألفاظاً مختلفة ومعانيها متفقة أو متقاربة أن ننظر
فيها، فإن نبهنا على موضع خلاف في المعاني حملنا تلك الألفاظ على مقتضى
اللغة وموجب الحكمة في وضع الكلام، فنجعلها من الألفاظ المتباينة التي
اختلفت باختلاف المعاني.
وهي السبيل الواضحة، والطريقة الصحيحة التي يسقط معها سؤال السائل وشك
المتشكك.
فإن لم يقع لنا موضع الخلاف في المعاني ولم يدلنا عليه النظر حملناه على
الأصل الآخر، وصرفناه إلى القسم الذي بيناه وشرحناه من الضرورة الداعية في
الشعر والخطابة إلى إستعمال الألفاظ الكثيرة الدالة على معنى واحد.
فلما وجدت المسائل التي صدرت في هذه الرسالة قد مثل فيها بألفاظ
بعينها - تكلفت الكلام فيها ليستعان بها على نظائرها، فإنها عند التصفح
كثيرة واسعة جداً، والله الموفق.
أما الفرق بين العجلة والسرعة، فإن العجلة على الأكثر تستعمل في الحركات
الجسمانية التي تتوالى، وأكثر ما تجيء في موضع الذم، فإنك تقول للرجل:
عجلت علي وعجل فلان على فلان فيعلم منه أنه ذم، وأنت لا تفهم هذا المعنى
من أسرع فلان.
وأيضاً فإنك لا تستعمل الأمر من العجلة إلا لأصحاب المهن الدنية، ولا
تقوله إلا لمن هو دونك.
فأما السرعة، فإنها من الألفاظ المحمودة، وأكثر ما تجيء في الحركات غير
الجسمانية، وذاك أنك تقول فلان سريع الهاجس، وسريع الأخذ للعلم، وقد أسرع
في الأمر وأسرع في الجواب، " بسم الله الرحمن الرحيم " والله سريع الحساب
صدق الله العظيم " وفرس فلان أسرع من الريح وأسرع من البرق، ويقال في
الطرف سريع، وفي القضاء سريع، والفلك سريع الحركة، ولا يستعمل بدل هذه
الألفاظ عجل، ولا تنصرف لفظة العجلة في شيء من هذه المواضع.
وهذا فرق واضح، ولكن الإتساع في الكلام، وتقارب المعنيين يحمل الناس على
وضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى.
وأما قولهم سر فلان وفرح، وأشر ومرح، فإن الفرق بين السرور والفرح وبين
الأشر والمرح ظاهر، فإن الأشر والمرح لا يستعملان إلا في الذم والعيب،
وأما السرور والفرح فليسا من ألفاظ الذم.
ووضوح الفرق ههنا أظهر وأبين من أن يحتاج فيه إلى تكلف شرح وبيان.
فأما السرور والفرح، وإن كانا متقاربين في المعنى فإن أحدهما وهو السرور
لا يستعمل إلا إذا كان فاعله بك غيرك.
وأما الفرح فهو حال تحدث بك غير فاعل، وتصريف الفعل منهما يدل على صحة ما
ذكرناه، وذلك أنك تقول: سررت وسر فلان، ولا يستعمل فيه إلا لفظ فعل الذي
هو وإن لم يسم فاعله فهو فعل غيرك.
فأما قولك: فرحت وفرح فلان فليس تقتضي اللفظة فاعلاً آخر.
وأما بعد فلان ونزح، فبينهما أيضاً فرق، وذلك أن البعد في المسافات على
أنواع، وإن كان يجمعها هذا الاسم، فإن الأخذ في الطول والعرض والعمق مختلف
الجهات وإن كان الجنس واحداً، فلما اختلفت الجهات، وكانت كل واحدة منها
خلاف الأخرى - وجب أن تختلف الألفاظ الدالة عليها، فلفظة البعد وإن كان
كالجنس مستعملة في كل واحدة من الجهات، فإنه يختص بالأخذ طولاً.
وأما لفظة نزح فإنه يختص بالأخذ عمقاً، فأصله في البئر وما جرى مجراها من
العمق، ثم حملهم الإتساع في الكلام - وأن العمق أيضاً بعد ما - على أن
أجروه مجرى الطول.
وأما هزل فلان ومزح، فبينهما فرق، وذلك أن الهزل هو ضد الجد، وهو مذموم.
فأما المزح فليس بمذموم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا
حقاً، ولم يكن يهزل.
ويقال: فلان حسن الفكاهة مزاح، يوصف به ويمدح، فإذا هزل عيب وذم.
فأما قولهم: حجب فلان وصد، فإن الحجاب معنى سابق، وكأنه سبب للصدود، ولما
كان الصدود هو الإعراض بالوجه - وإنما يقع هذا الفعل بعد الحجاب منه - صار
قريباً فاستعمل مكانه، وبين المعنيين تفاوت.
فأما الألفاظ الأخر التي ذكرت بعد فإن المتأمل لها يعرف الفرق بينهما،
بأدنى تأمل، ولذلك تركت الكلام فيها؛ إذ كان أعطى، أصله من عطا يعطو،
وإنما عدى بالهمزة، كما تقول قام فلان وأقامه غيره.
وأما ناول فهو فاعل من النول، وحاول فعل من الحول.
وهذه الأشياء من الظهور بحيث يستغني عن الكلام فيها.
وأما قولهم جلس فلان وقعد، فإن الهيئة وإن كانت واحدة، فإن الجلوس لما كان
بعقب تكاء واستلقاء، والقعود لما كان بعقب قيام وانتصاب - أحبوا أن يفرقوا
بين الهيئتين الواقعتين بعقب أحوال مختلفة.
والدليل على أنهم خالفوا بين هاتين اللفظتين لأجل الأحوال المختلفة قبلهما
أنك تقول: كان فلان متكئاً فاستوى جالساً، ولا تقول استوى قاعداً.
ولست أقول: إن هذا الحكم واجب في كل لفظتين مختلفتين إذا دلتا على معنى،
ولا هو حتم عليك ولا ضربة لا زب لك، بل قد قدمنا أما هذه المسألة ما جعلنا
لك فيه فسحة تامة، ورخصة واسعة: إذا لم تجد الفرق واضحاً بيناً أن تذهب
بهما إلى الاتفاق في الاسم الذي هو أحد أقسام الألفاظ التي عددناها.
ثم قلت في آخر المسألة: ما الفرق بين المعنى والمراد والغرض؟
وبينهما فروق بينة، وذلك أن المعنى أمر قائم بنفسه مستقل بذاته، وإنما
يعرض له بعد أن يصير مراداً، وقد يكون معنى ولا يكون مراداً.
فأما الغرض فأصله المقصود بالسهم، ولكنه لما كان منصوباً لك تقصده بالحركة
والإرادة صار كالغرض للسهم، فاستعملت هذه اللفظة ههنا على التشبيه.
وأما قولك في خاتمة المسألة: ما الذي أوضح الفرق بين نطق وسكت، وألبس
الفرق بين سكت وصمت؟ فما أعجبه من مطالبة، وأغربه من مسألة! كيف لا يكون
الفرق بين المتضادين اللذين هما في الطرفين والحاشيتين، وأحدهما في غاية
البعد عن الآخر - أوضح من الشيئين المتقاربين اللذين ليس بينهما إلا بعد
وأمد قريب يخفى على الناظر إلا بعد حده النظر واستقصاء التأمل؟ على أن
الفرق بين صمت وسكت أيضاً غير ملتبس؛ لأن السكوت لا يكون إلا من متكلم،
ولا يقع إلا من ناطق.
وأما الصمت فليس يقع إلا عن نطق لا محالة؛ لأنه يقال: جاء فلان بما صاء
وصمت، يعني به ضروب المال الحي منه والجماد.
ولا يقال في المال: صامت إلا لما كان غير ذي حياة ولا نطق ولا صوت، كالذهب
والفضة، وما جرى مجراها من الجمادات.
وأما المال الذي هو ماشية وحيوان فلا يقال له: صامت، ولا يقال للصامت من
المال ساكت؛ لأن السكوت إنما يكون عن كلام أو صوت.
وقد يقال في الثوب إذا أخلق: سكت الثوب، وإنما ذلك على التشبيه، كأنهم لما
وجدوه جديداً يصوت ويقعقع شبهوه بالمتكلم، ثم لما أمسك عند الإخلاق شبهوه
بالساكت، وهذا من ملح الكلام وطرف المجاز.
مسألة خلقية لم تحاث الناس على كتمان الأسرار
وتبالغوا في أخذ العهد به
وحرجوا من الإفشاء، وتناهوا في التواصي بالطي ولم تنكتم مع هذه المقامات؟ وكيف فشت وبرزت من الحجب المضروبة حتى نثرت في المجالس، وخلدت في بطون الصحف، وأوعيت الآذان، ورويت على الزمان؟ ومن أين كان فشوها مع الإحتياط في طيها؟ نعم ومع الخوف العارض في نشرها، والندم الواقع من ذكرها، والمنافع الفائتة، والعواقب المخوفة، والأسباب المتلفة؟ الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد تبين في المباحث الفلسفية أن للنفس قوتين إحداهما معطية، والأخرى آخذه.فهي بالقوة الآخذة تستثيب المعارف، وتشتاق إلى تعرف الأخبار، وبها يوجد الصبيان أول نشوئهم محبين لسماع الخرافات، فإذا تكهلوا أحبوا معرفة الحقائق.
وهذه القوة هي انفعال وشوق إلى الكمال الذي يخص النفس.
وهي بالقوة المعطية تفيض على غيرها ما عندها من المعارف، وتفيده العلوم الحاصلة لها، وهذه القوة ليست انفعالاً بل فاعلة.
وهاتان القوتان موجودتان للنفس بالذات لا بالعرض.
فكل إنسان يحرص بإحدى قوتيه على الفعل، وهو الإعلام، وبالأخرى على الانفعال، وهو الاستعلام.
ولما كان ذلك كذلك لم يمكن أن ينفعل المنفعل، ولا يفعل الفاعل، ولا أن يفعل الفاعل، ولا ينفعل المنفعل؛ لأنهما جميعاً للنفس بالذات.
فقد ظهر السبب الداعي إلى إخراج السر، وهو أن النفس لما كانت واحدة واشتاقت بإحدى قوتيها إلى الاستعلام، واشتاقت بالأخرى إلى الأعلام - لم ينكتم سر بتة.
وهذا هو تدبير إلهي عجيب، ومن أجله نقلت الأخبار القديمة، وحفظت قصص الأمم، وعني المتقدمون بتدوين ذلك وحرص المتأخرون على نقله وقراءته.
ولذلك ضرب الحكماء فيه المثل، وحزموا عليه القول، وقطعوا به الحكم وقالوا: لا ينكتم سر، وإنما يتقدم ظهوره أو يتأخر.
وتقول العامة: أي شيء ينكتم؟ ثم تقول في الجواب: ما لا يكون.
فحقيق على صاحب السر أن يستودعه إلا القادر على نفسه، والقاهر لنزواتها عند حركاتها وشهواتها، بل المجاهد لها، المعتاد عند الجهاد غلبها وقهرها.
وإنما يتم للإنسان ذلك بخاصة قوة العقل الذي هو أفضل موهبة الله تعالى، وأكبر نعمة له على العبد، وبه فضل الإنسان على سائر الحيوان.
ولولا هذا الجوهر الكريم الذي هو مسيطر على النفس ومشرف عليها، لكان الإنسان كسائر الحيوانات غير الناطقة في ظهور قوى النفس منه مرسلة من غير رقبة، ومهملة بغير رعية، ولكنه بهذا الجوهر النفيس في جهاد للنفس عظيم.
ومعنى قولي هذا أن الإنسان دائماً في جهاد النفس بقوة عقله؛ لأنه
محتاج إلى ردعها به، وإلى ضبطها ومنعها من شهواتها الردية حتى لا يصيب
منها إلا بمقدار ما يطلقه العقل ويحده لها، وما يرسمه ويبيحه إياها.
ومن لم يقم بهذا الجهاد مدة عمره فليس ممن له حظ في الإنسانية، بل هو خليع
كالبهيمة المهملة التي لا رقيب عليها من العقل.
وإذا انحط الإنسان عن رتبته العالية إلى رتبة ما هو أدنى منه، فقد خسر
نفسه ورضى لها بأخسر المنازل، هذا مع كفره نعمة الله، ورده الموهبة التي
لا أجل منها، وكراهيته جوار بارئه، ونفوره من قربه.
وقد شرح الحكماء هذا المعنى واستقصوه، وعلموا الناس جهاد النفس في كتب
الأخلاق، فمن اشتاق إلى معرفة ذلك فليأخذ من هناك.
فانفعالات النفس وأفعالها بحسب قوتها كثيرة، وهي الشهوات الموجودة في
الناس، وليس يخلو منها البشر، ولكنها فيهم بالأكثر والأقل، فمجاهدة
العقلاء لها مختلفة، والجهال هم المسترسلون فيها غير المجاهدين لها.
وإخراج السر من جملة هذه الشهوات، وهو متعلق بالإخبار والإعطاء، إذا كان
لحفظ السر هذا الموقع من المجاهدة للنفس لأنها تحرص في إظهاره على أمر
ذاتي لها، وإنما يقمعها العقل ويمنعها - فأخلق به أن يكون صعباً شديداً،
جارياً مجرى غيره من شهوات النفس التي يقع الجهاد فيها.
وربما وجدت إحدى هاتين القوتين في بعض الناس أقوى والأخرى أضعف، فإن من
الناس من يحرص على الحديث، ومنهم من يحرص على الاستماع، ومنهم الضنين
بالعلم، ومنهم السمح به، ومنهم الحريص على التعلم والاستفادة، ومنهم
الكسلان عنه وعلى هذا يوجد بعضهم أحرص على إخراج السر، وبعضهم أثبت وأحسن
تماسكاً.
وكان لنا صديق صاحب السلطان قريب المنزلة منه، فكان يقول لصاحبه: إذا كان
لك سر تحب كتمانه، وتكره إذاعته فلا تطلعني عليه، ولا تجعلني موضعه، ولا
تبلني بحفظه؛ فإنه أجد له في صدري وخزاً كوخز الأشافي، ونخس الأسنة.
وسمعته يقول: اطلعت على سر للوزير، فجعل لي على كتمانه وطية مالاً
وألطافاً، حملت إلي في الوقت، فعزمت على الوفاء له، وحدثت نفسي به،
ووطنتها عليه، فبت بليلة السليم، وأصبحت وقيذاً، فلم أجد حيلة لما أجد من
الكرب غير أني ذهبت إلى ناحية من الدار خالية فيها دولاب خراب، فنحين من
كان حولي ثم قلت: أيها الدولاب، من الأمر والقصة كذا وكذا.
وأنا والله أجد من الراحة ما يجده المثقل بالحمل إذا خفف عنه، وكأنني
فرغته من وعاء ضيق إلى أوسع منه، ثم لم ألبث أن عادت الصورة في ثقله،
وجثومه على قلبي إلى أن كفيته بظهوره من جهة غيري.
وهذا الذي قد نثره الرجل قد نظمه الآخر، فقال:
ولا أكتم الأسرار لكن أنمها ... ولا أدع الأسرار تغلي على قلبي
فإن قليل العقل من بات ليلة ... تقلبه الأسرار جنباً إلى جنب.
يروي: وإن غبين الرأى.
وقد سبق المثل المضروب بالملك الذي كأن أذنه أذن حمار، فإن صاحب ذلك المثل
أراد أن يبالغ في الوصاة، بحفظ السر، فأخبر أن الشجر والمدر غير مأمون على
السر، وأنه ينم به فكيف الحيوان؟ وهذا ما تقول العامة: للحيطان آذان.
وأما قول الشاعر:
وإخوان صدق لست مطلع بعضهم ... على سر بعض غير أني جماعها
يظلون شتى في البلاد وسرهم ... إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها.
وقول الآخر: وأكتم السر فيه ضربة العنق.
فكلام لا يصح، ودعوى لا تثبت، فاسمعه سماعاً، وإياك والإغترار به.
مسألة مركبة من أسرار طبيعية وحروف لغوية
وهي: لم ثار اسم من الأسماء أخف عند السماع من اسم
حتى إنك لتجد الطرب يعترى سامع ذاك؟ أنا رأيت بعض من كان يهوى البحتري ويخف لحديثه، ويتعصب لقريضه يقول: ما أحسن تشبيب البحتري بعلوة، وما أحسن اختياره علوة، ولا يجد هذا في سلمي وهند وفرتنا ودعد.وهذا عارض موجود في الأسماء والكنى والشمائل والحلى، والصور والبني، والأخلاق والخلق، والبلدان والأزمان، والمذاهب والمقالات، والطرائق والعادات.
وإذا بحثت عن هذا الباب فصله بالبحث عما ثقل على النفس والسمع والطبع من هذه الأشياء، فإنه إن كان قبولها لعلة فمجها لعلة، وإن كان وصالها لسبب فصدودها لسبب.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: الاسم مركب من الحروف،
والحروف عددها ثمانية وعشرون، وتركيبه يكون ثنائياً وثلاثياً ورباعياً
وخماسياً.
والأولى في جواب هذه المسألة أن نتكلم في الحروف المفردة التي هي بسائط
الأسماء، ثم بعد ذلك في الأسماء المركبة منها، ليبين موضع استحلاء السامع
للحروف المفردة، ثم لمزج هذه الحروف وتركيبها، ثم لوضع اللفظة إلى جانب
اللفظة حتى تصير منها خطبة أو بيت شعر أو غير ذلك من أقسام الكلام، فإن
مثل ذلك العقود والسموط المؤلفة من خرزات مختلفة في القد واللون والجوهر
والخرط.
وقد علم أن للعقد المنظوم من النفس ثلاثة مواضع: أحدها مفردات تلك الخرز
واختيار أجناسها وجواهرها.
والثاني موقع النظم الذي يجعل للحبة إلى جانب الحبة قبولاً آخر، وموضعاً
من النفس ثانياً.
والثالث وضع كل واحد من هذه العقود في خاص موضعه من النحر والرأس والزند
والصدر.
وإذا كان هذا المثال صحيحاً، وكانت الحروف الأصلية كالخرز، وهي مختلفة
اختلافاً طبيعياً لا صنع فيها للبشر، ولا يظهر فيها أثر للصناعة ولا ريبة
للحذق والمهارة - كان القسمان الباقيان من النظم والتركيب هما موضع
الصناعة، وفيهما يظهر أثر الإنسان بالحذق وجوده البصر والثقافة.
وبيان ذلك: أن الحروف الثمانية والعشرين يطلع كل واحد منها من مطلع غير
مطلع الآخر، وذلك من أقصى الرئة إلى أدنى الفم، على ما قسمه أصحاب اللغة
وبينه الخليل وغيره، وعلى خلاف بينهم في مخارجها ومواضعها، وموضعنا هذا لا
يليق بشرح هذا الكلام؛ فإنه يعوقنا عن قصدنا وبغيتنا.
ونقول: إن الصوت إنما يتم بآلة هي الرئة وقصبتها لأنها مستطرق الهواء،
والصوت إنما هو اقتراع في الهواء، ولما لم يكن للهواء طريق في الإنسان إلا
من الرئة وقصبتها، والمدخل إليها من الفم، ولا مخرج له إلا من هذه الجهة -
جعل اىقتراع - الذي هو الصوت - في هذه المسافة حسب، فبعض الأصوات أقرب إلى
الرئة وأبعد من الشفة، وبعضها أقرب إلى الشفة وأبعد من الرئة، والوسائط
بين هذين الموضعين كثيرة.
فالنفس وهو الهواء إذا خرج من الرئة إلى أن يبلغ الشفة له مسافة بين أقصى
الحلقوم وبين منتهى الفم، والإنسان مقتدر على تقطيع هذا الهواء
بالاقتراعات المختلفة غي طول هذه المسافة، فيخرق هذا الهواء مرة في أقصى
الحلق، ومرة في أدناه، ومرة في غار الفم، إلى أن يصير لها ثمانية وعشرين
موضعاً.
ومثال ذلك مثل مزمار فيه ثقب متى أطلق الإنسان فيه النفس وخرق موضعاً
بإصبع إصبع اختلفت الأصوات في السمع بحسب قربه وبعده.
ولا يكون المسموع من الاقتراع الذي يحدث عند الثقب الأخير المسموع من
الاقتراع الذي يحدث عند الثقب الأول.
وكذلك سائر الاقتراعات التي بين هذين الثقبين مختلفة المواقع من السمع، لا
يشبه واحد الآخر، فيقال لبعضها: حاد، ولبعضها: حلو، ولبعضها: جهير،
ولبعضها: لين.
وكل واحد من هذه الأصوات له أثر في النفس وموقع منها، ومشاكلة لها.
وليس للسائل أن يكلفنا بحسب هذا البحث الذي نحن فيه، أن نتكلم في سبب قبول
النفس بعض الأصوات أكثر من بعض؛ لأن هذا النظر والبحث يتعلق بصناعة
الموسيقى ومبانيها، ومعرفة أقدار النغم المختلفة بالنسب التي هي نسبة
المساواة، ونسبة الضعف، ونسبة الضعف والنصف، وأشباهها.
وهذه النسب بعضها أقرب إلى قبول النفس من بعض، حتى قال بعض الأوائل: إن
النفس مركبة من عدد تأليفي.
فلما كانت قصبة الرئة كقصبة المزمار، وتقطيع الحروف فيها كخرق الصوت
بالمزمار في موضع بعد موضع، وكانت الأصوات في المزمار مختلفة القبول عند
النفس - كانت الحروف كذلك أيضاً لا فرق بينها وبينها بوجه ولا سبب.
فقد بان أن الحروف أنفسها مفردة لها مواقع من النفس مختلفة، فبعضها أوقع
عندها من بعض.
وإذا كانت بهذه الصفة وهي مفردات وبسائط كان تركيبها أيضاً مختلفاً في
قبول النفس، سوى أن للتركيب والتأليف تعلقاً بالصناعة كما ضربنا به المثل
في نظم الخرز ونظم الأصوات في الموسيقى؛ لأن الموسيقار ليس يعمل أكثر من
تأليف هذه الأصوات بعضها إلى بعض على النسب الموافقة للنفس.
فمؤلف الحروف يجب أن يؤلفها أيضاً ويمزجها مزجاً موافقاً من الثنائي
والثلاثي وغيرهما، إذا أحب أن يكون لها قبول من النفس.
فقد تبين إلى هذا الموضع سبب خلاف هذه الحروف مفردة، ثم مركبة،
وأنه بحسب هذا البيان يجب أن يكون بعض الأسماء أحسن من بعض، وأعذب في
السمع، وأقرب إلى قبول النفس، وبعضها أبعد في هذه الأشياء.
وبقي الاعتبار الثالث الذي هو نظم الكلم بعضه إلى بعض، ووضعه في خواص
مواضعه؛ ليصدق المثال الذي ضربناه في الخرز والعقود، ثم وضع كل عقد حيث
يليق به.
وههنا تظهر صناعة الخطابة والبلاغة والشعر، وذلك أنه إذا اختار المختار
الحروف المؤلفة بالأسماء حتى لا يكون فيها مستكره ولا مستنكر، ووضعها من
النظم في مواضعها، ثم نظمها نظماً آخر - أعني وضع الكلمة إلى جنب الكلمة -
موافقاً للمعنى غير قلق في المكان، ولا نافر عن السمع - فقد استتمت له
الصناعة إما شعراً وإما خطبة وإما غيرهما من أقسام الكلام.
ومتى دخل عليه الخلل في أحد هذه المواضع الثلاثة اختلت صناعته، وأبت النفس
قبول ما نظمه من الكلام بحسب ذلك.
فقد لخصنا وشرحنا هذه المسألة تلخيصاً وشرحاً كافياً إن شاء الله.
فأما سؤالك في آخر مسألتك أن أصل هذا البحث بالبحث عما ثقل على النفس
والسمع والطبع فقد فعلت ذلك، فظهر في أثناء كلامي، وذلك أنه إذا بان سبب
أحد الضدين بان سبب الضد الآخر.
والأصوات المستكرهة التي ليس لها قبول في النفس كثيرة، ولا عناية للناس
بها فتؤلف، وإنما تجدها مفردة بالاتفاق كصرير الباب، وصوت الصفر إذا جرده
الصفار، وما أشبههما، فإن النفس تتغير من هذه فتقشعر، وربما قام له شعر
البدن، حدث بالنفس منه دوار حتى ينكر الإنسان حاله.
وهو معروف بين.
مسألة اختيارية لم تواصى الناس في جميع اللغات والنحل
وسائر العادات والملل بالزهد في الدنيا
والتقلل منها والرضا بما زجا به الوقت، وتيسر مع الحال، هذا مع شدة الحرص والطلب، وإفراط الشره والكلب، وركوب البر والبحر بسبب ربح قليل، ونائل نزر، حتى إنك لا تجد على أديمها إلا متلفتاً إلى فانيها حزيناً، أو هائماً على حاضرها مفتوناً، أو متمنياً لها في المستقبل معنى، وحتى لو تصفحت الناس لم تجد إلا منحسراً عليها، أو متحيراً فيها، أو مسكراً منها.وأشرفهم عقلاً أعظمهم خبلاً، وأشدهم فيها إزهاداً أشدهم بها انعقاداً، وأكثرهم في بعضها دعوى أكثرهم في حبها بلوى.
وهات السبب في ذلك والعلة، وعلى ذكر السبب والعلة فما السبب والعلة؟ وما الواصل بينهما إن كان واصل؟ وهل ينوب أحدهما عن الآخر؟ وإن كانت هناك نيابة أفهي في كل مكان وزمان؟ أو في مكان دون مكان، وزمان دون زمان؟.
وعلى ذكر المكان والزمان، ما الزمان وما المكان؟ وما وجه التباس أحدهما بالآخر؟ وما نسبة أحدهما بالآخر؟ وهل الوقت والزمان واحد؟ والدهر والحين واحد؟ وإن كان كذا فكيف يكون شيئآن شيئاً؟ وإن جاز أن يكون شيئآن شيئاً واحداً هل يجوز أن يكون شيء واحد شيئين اثنين؟ هذا - أيدك الله - فن ينشف الريق، ويضرع الخد ويجيش النفس، ويقيىء المبطان.
ويفضح المدعى، ويبعث على الإعتراف بالتقصير والعجز، ويدل على توحيد من هو محيط بهذه الغوامض والحقائق، ويبعث على عبادة من هو عالم بهذه السرائر والدقائق، وينهي عن التحكم والتهانف، ويأمر بالتناصف والتواصف، ويبين أن العلم بحر، وفائت الناس منه أكثر من مدركه، ومجهوله أضعاف معلومة، وظنه أكثر من يقينه، والخافي عليه أكثر من البادي، وما يتوهمه فوق ما يتحققه، والله تعالى يقول: " بسم الرحمن الرحيم " ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء " صدق الله العظيم " .
فلو استمر المعلوم بالنفي لما علم شيء، ولولا الإيضاح بالإستثناء لما بقي شيء، لكنه جل وهز نفى بلا على ما يقتضيه التوحيد، وبقي بإلا ما يكون حلية ومصلحة للعبيد.
ثم أتبعت المسألة من تنقص الإنسان وذمه وتوبيخه ما أستغنى عن أثباته.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رجمه الله: هذه المسألة موشحة بعدة مسائل طبعية، وقد جعلتها مسألة واحدة، ولعل التي صيرتها أذناباً هي أشبه بأن تكون رؤوساً.
وقد عرض لك فيها عارض من العجب، وسانح من التيه، فخطرت خطران الفحل ومشيت العرضنة، ومررت في خيلائك، ومضيت على غلوائك حتى أشفقت أن تعثر في فضل خطابك، فلو تركت هذا الغرض للمتكلم على مسائلك، ووفرت هذا المرض على المجيب لك؟.
ارفق بنا يا ابا حيان - رفق الله - وأرخ من خناقنا، وأسغنا
ريقنا، ودعنا وما نعرفه في أنفسنا من النقص فإنه عظيم، وما بلينا به من
الشكوك فإنه كثير، ولا تبكتنا بجهل ما علمناه، وفوت ما أدركناه، فتبعثنا
على تعظيم أنفسنا، وتمنعنا من طلب ما فاتنا، فإنك - والله - تأثم في
أمرنا، وتقبح فينا، أسأل الله أن لا يؤاخذك ولا يطالبك ولا يعاقبك؛ فإنك
بعرض جميع ذلك إلا أن يعفو ويغفر، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة.
أما أولى المسائل فالجواب عنها: أن الإنسان لما كان مركباً من نفس وجسد،
واسم الإنسانية واقع على هذين الشيئين معاً.
وأشرف جزأي الإنسان النفس التي هي معدن كل فضيلة، وبها وبعينها يرى الحق
والباطل في الاعتقاد، والخير والشر في الأفعال، والحسن والقبيح في
الأخلاق، والصدق والكذب في الأقاويل.
وأما جزؤه الآخر الذي هو الجسم وخواصه وتوابعه فهو أرذل جزأيه وأخسهما؛
وذلك أنه مركب من طبائع مختلفة متعادية، ووجوده في الكون دائماً لا لبث له
طرفة عين، بل هو متبدل سيال؛ ولهذا سمى عالمه العالم السوفسطائي.
وهذه مباحث محققة مشروحة في مواضعها، وإنما ذكرنا بها لحاجتنا في جواب
المسألة إليها.
فإذا كان الإنسان مركباً من هذين الجزأين، وممزوجاً من هاتين القوتين،
وكان أشرف جزأيه ما ذكرناه - وهو النفس التي ليس وجودها في كون، ولا هي
متركبة من أجزاء متعادية متضادة، بل هي جوهر بسيط بالإضافة إلى الجسم، وهي
قوة إلهية غنية بذاتها - وجب أن يكون شغل الإنسان بهذا الجزء أفضل من شغله
بالجزء الآخر؛ لأن هذا باق وذاك فان، وهذا جوهر واحد، وذاك جواهر متضادة،
وهذا له وجود سرمدي، وذاك لا وجود له إلا في الكون الذي لا ثبات له.
وفي عدنا فضائل النفس، ونقائص الجسم خروج عن غرض هذه المسألة.
والذي يكفي في الجواب عن هذه المسألة بعد تقرير هذه الأصول والإقرار بها،
أن الإنسان إذا أحس بهذه الفضائل التي في نفسه، والرذائل التي في جسمه -
وجب عليه أن يستكثر من الفضائل ليرتقي بها إلى درجات الإلهيين، ويقل
العناية بما يعوق عنها.
ولما كان الشغل بالحواس وخصائص الجسم عائقاً عن هذه الفضائل والعلوم
الخاصة بالإنسان، استقبح أهل كل ملة الإنهماك فيه، وصرف الهمة والبال
إليه، وأمروا بأخذ قوته الذي لا بد له منه في مادة الحياة، وصرف باقي
الزمان بالهمة إلى تلك الفضائل التي هي السعادة.
وهذا المعنى يلوح للناظر، ويبين له بياناً جلياً، إذا نظر إلى فوق ما بين
الإنسان وسائر الحيوانات، لأنه إنما فضلها بخاصة النفس لا بخواص الجسد؛
لأن خواص الجسد للحيوانات أتم وأغزر - وقد علم أن الإنسان أفضل منها -
وأعنى بخواص الجسد، الأيد والبطش والقدرة على الأكل والشراب والجماع وما
أشبه ذلك، فإذا تمامية الإنسان وفضيلته إنما هي بهذه المزية التي وجدت له
دون غيره، فالمستريد منها أحق باسم الإنسانية، وأولى بصفة الفضيلة؛ ولهذا
يقال: فلان كثير الإنسانية، وهو من أبلغ ما يمدح به.
ومن أحب الاطلاع على تلك الأصول، والاستكثار منها وبلوغ غاية اليقين فيها
فليأخذه من مظانه.
فأما حرص الناس - مع شعورهم بهذه الفضيلة - وكلبهم على الدنيا بركوب البر
والبحر لأجل الملاذ الخسيسة؛ فلأن الجزء الذي فينا معاشر البشر من الجسم
الطبيعي أقوى من الجزء الآخر.
وعرض لنا من تجاذب هاتين القوتين ما يعرض لكل مركب من قوى مختلفة، فيكون
الأقوى أبداً أظهر أثراً؛ فلأجل ذلك انجذبنا إلى هذا الجزء مع علمنا
بفضيلة الجزء الآخر.
ونحن وإن علمنا أن هذا كما حكيناه، وتيقنا هذا المذهب تيقناً لا
ريب فيه، فإنا في جهاد دائم، فربما غلب علينا هذا الجزء، وربما ملنا إلى
الجزء الآخر بحسب العناية، وسأضرب في ذلك مثلاً من العيان والحس، وهو أن
المريض والناقة والخارج عن مزاج الاعتدال قد تيقن أنه بالحمية وترك
الشهوات يعود إلى الصحة والاعتدال الطبيعي، وهو مع ذلك لا يمتنع من كثير
من شهواته، لشدة مجاذبتها له، وغلبتها على صحيح عقله، وثاقب فكره، ونصيحة
طبيبه، حتى إذا فرغ من مواقعه تلك الشهوة وأحس بالألم، ندم ندامة يظن معها
ألا يعاود أبداً، ثم لا يلبث أن تهيج به شهوة أخرى أو هي بعينها، وهو في
ذلك يعظ نفسه، ويديم تذكيرها الألم، ويشوقها إلى الصحة، ولا ينفعه وعظ ولا
تذكير، للعلة التي ذكرناها قبل من شدة مجاذبة الشهوة الحاضرة، حتى ينال
شهوته ثانياً، ثم هذه حال مستمرة به ما دام مريضاً.
وكذلك هو أيضاً في حالة الصحة، يتناول من الشهوات ما يعلم أنه يخرج عن
مزاج الاعتدال، ولا يأمن هجوم الأمراض عليه، فيحمله سوء التحفظ وشدة
مجاذبة الطبيعة إلى مخالفة التمييز، ومشاركة البهائم.
فإذا رأيت هذا المثل صحيحاً، ووجدته من نفسك ضرورة، اطلعت على ما قدمناه،
وفهمته فهماً بيناً، وعذرت من زهدك في الدنيا وإن خالفك إليها ومن نصحك
بتركها وإن أخذ هو بها واستكثر منها.
فأما ما اعترض في المسألة من ذكر السبب والعلة، والمسألة عن الفرق بينهما،
فإن السبب هو الأمر الداعي إلى الفعل، ولأجله يفعل الفاعل.
فإما العلة فهي الفاعلة بعينها؛ ولذلك صار السبب أشد اختصاصاً بالأشياء
العرضية، وصارت العلة أشد اختصاصاً بالأمور الجوهرية.
والحكماء قد أطلقوا لفظ العلة على الباري تقدس اسمه، وعلى العقل، والنفس،
والطبيعة، حتى قالوا: العلة الأولى، والعلة الثانية والثالثة والرابعة،
وقالوا أيضاً: العلة القريبة والعلة البعيدة، في أشياء تتبينها من كتبهم.
وعلى أن هذه المسألة - بجهة من الجهات - تنحل إلى المسألة الأولى وتعود
إليها؛ لأنها يجوز أن توجد في المتباينة اسماؤها بضرب من الاعتبار، وفي
المترادفة أسماؤها بضرب آخر من الاعتبار، وقد مر هذا الكلام مستقصى فلا
وجه لإعادته.
وأما الزمان والمكان، فإن الكلام فيهما كثير، قد خاض فيه الأوائل، وجادل
فيه أصحاب الكلام الإسلاميون، وهو أظهر من أن ينشف الريق، ويضرع فيه
الخد،ولا سيما وقد أحكم القول فيه الحكيم، وناقص أصحاب الآراء فيهما، وبين
فساد المذاهب القديمة، وذكر رأى نفسه ورأى أستاذه في كتاب السماع الطبيعي
وكل شيء وجد لهذا الحكيم فيه كلام فقد شفى وكفى، وقد فسر كلامه فضلاء
أصحابه المفسرين، ونقل إلى العربية، وهو موجود.
وأنا أذكر نص المذاهب لما تقتضيه مسألتك في عرض المسألة الأولى، وأترك
الاحتجاج لأنه مسطور، وإذا دللت على موضعه فقرىء منه كان أولى من نقله إلى
هذا المكان نسخاً.
أما الزمان فهو مدة تعدها حركات الفلك.
وأما المكان فهو السطح الذي يجوز المحوي والحاوي.
وأما الفرق الذي سألته بين الوقت والزمان، والدهر والحين، فإن الوقت قدر
من الزمان مفروض مميز من جملته، مشار إليه بعينه.
وكذلك الحين هو مدة أطول من الوقت وأفسح وأبعد، وإنما تقترن أبداً هاتان
اللفظتان بما يميزهما ويفصلهما من جملة الزمان الذي هو كل لهما، فيقال:
وقت كذا وحين كذا، فينسب إلى حال أو شخص أو ما أشبه ذلك.
فإذا أريد بهما الإبهام لا الإفهام قيل: كان كذا أو يكون كذا في حين أو
وقت، فيعلم السامع أن المتكلم لم يؤثر تعيين الوقت والحين، وهما لا محالة
معينان محصلان.
فأما الدهر فليس من الزمان ولا الحين ولا الوقت في شيء، ولكنه أخص
بالأشياء التي ليست في زمان ولا مقدرة بحركات الفلك؛ لأنها أعلى رتبة من
الأمور الطبيعية.
فأقول: نسبة الزمان إلى الأمور الطبيعية كنسبة الدهر إلى الأمور غير
الطبيعية، أعنى ما هو فوق الطبيعية.
وهذا القدر من الكلام كاف في الإيماء إلى ما سألت عنه، وإن أحببت التوسع
فيه فعليك بالمواضع التي أرشدناك إليها من كلام الحكيم ومفسري كتبه؛ فإنه
مستقصى هناك.
وهذه المواضع - أبقاك الله - إذا نظر فيها الإنسان وعرفها حق معرفتها،
تنبه على حكمة بارئها، ومبدئها، وصارت أسباباً محكمة، ودواعي قوية إلى
التوحيد.
وليس معرفتنا بها، وإحاطتنا بعلمها إلا من نعمة الله علينا،
وإفاضته الخير بها علينا، وهي مما شاء أن نحيط به من علمه، ولم يكن علمنا
بالزمان والمكان والوقت والآن إلا كسائر ما علمناه الله.
ووراء هذه المواضع سرائر ودقائق لا يبلغها العقل الإنساني، ولم يطمع في
إدراكها أحد قط، وهناك يحسن الاعتراف بالضعف البشري، والعجز الإنساني،
وسائر ما تكلم فيه أو حيان، ورمى الإنسان به من الذلة والقلة فيقعى حينئذ
على أسته، ويستحي من الفسولة والذل عند الحاجة إلى خالق الخلق، وبارىء
الكل.
فأما هذه المواضع التي تكلمنا فيها فهي مواضع الشكر له، والتحدث بنعمته
والتعجب من حكمته، والاستدلال بها على جوده وقدرته وفيضه بالخير على بريته.
ومسألته الزيادة منها، والحرص على نيل أمثالها بالنظر والفحص، وإدامة
الرغبة إلى واهبها ومنيلها بإفاضة أشباهها وأشكالها، مما هو موضوع للبشر
وميسر لهم، وهم مندوبون له مبعوثون عليه؛ بل أقول إنه مأخوذ على الإنسان
الكامل بالعقل ألا يقعد عن السعي والطلب لتكميل نفسه بالمعارف، ولا يني
ولا يفتر مدة عمره عن الازدياد من العلوم التي بها يصير من حزب الله
الغالبين، وأوليائه الفائزين الآمنين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
فأما القوم الذين يفنون أعمارهم في قنية الذهب والفضة ويجعلون سعيهم كله
مصروفاً إلى الأمور الزائلة الفانية من اللذات الجسمانية والشهوات البدنية
- فهم الذين قد بعدوا من الله، وصاروا من حزب الشيطان، فوقعوا في الأحزان
الطويلة، والخوف الدائم، والخسوان المبين!!! إذ كانوا أبداً من مطلوبهم
على إحدى حالتين: إما أسف على فائت ونزاع إليه، أو لهف على مفقود وحزن
عليه؛ لأن الأمور التي يطلبونها لا ثبات لها، ولا نهاية لأشخاصها، ولا
وجود بالحقيقة لها، وإنما هي في الكون والإستحالة والتنقل بالطبع.
نسأل الله الواحد الذي نخلص إليه رغباتنا، ونرفع أيدي نفوسنا له، ونسجد
بهممنا وعقولنا - أن يفيض علينا الخير المطلوب منه الذي نشتاق إليه لذاته
لا لغيره، وأن ينير عقولنا لندرك بها حقيقة وحدانيته، وعجائب مبروءآته،
ويفضى بنا إلى السعادة القصوى التي خلقنا لها من أقصر الطرق، وأهدى السبل،
صراط الله المستقيم؛ فإنه أهل ذلك ووليه، والقادر عليه.
مسألة اختيارية لم طلبت الدنيا بالعلم والعلم ينهى عن ذلك
؟ولم لم يطلب العلم بالدنيا والعلم يأمر بذلك؟ وقد يقول من ضعفت غريزته، وساء أدبه، جرؤ مقدمه: قد رأينا من ترك طلب الدنيا بالعلم، ورأينا من طلب العلم بالدنيا.
فليعلم أن المسألة ما وضعت هناك، ولا فرضت كذاك، ولو سدد هذا المعترض فكره عرف الفحوى، ولحق المرمى، ولم يعارض بادراً بشائع، ولم يناقض نادراً بذائع.
الجواب: أما طلب الدنيا فضروري للإنسان لما ذكرناه؛ فإن وجوده بأحد جزأيه طبيعي، ولا بد من إقامة هذا الجزء بمادته؛ لأنه سيال دائم التحلل، ولا بد من تعويض ما يتحلل منه.
ولم ينه العلم عن هذا المقدار فقد، وإنما نهى عن الزيادة على قدر الحاجة؛ إذ كانت الزيادة مذمومة من جهات: أحدها أنها تؤدي إلى تفاوت الجسم الذي سعينا لحفظ اعتداله.
والثاني أنها تعوقنا عما هو أخص بنا من حيث نحن ناس، أعنى الجزء الآخر الذي هو فضيلة.
فمن طلب بالعلم من الدنيا قدر الحاجة في حفظ الصحة على الجسد فهو مصيب تابع لما يرسمه العقل، ويأمر به العلم.
ومن طلب أكثر من ذلك فهو مفرط مسرف.
وموضع الاعتدال من الطلب هو الصعب، وهو الذي ينبغي أن يلقى فيه أهل الحكمة والعلم، وتقرأ له كتب الأخلاق؛ ليعرف الاعتدال فيلزم، ويعرف الإفراط فيحذر.
ولا بد مه هذه الجملة التي ذكرناها - وإن دللنا فيها على المواضع التي يرجع إليها - من أدنى كشف وبيان فنقول: إن الناس لما اختلفنظرهم بحسب جزئهم: فناظر إلى الطبيعة، وناظر إلى العقل، وناظر فيهما معاً - اختلفت مقاصدهم، وصارت أفعالهم تلقاء نظرهم.
وقد علم أن الناظر في أحد جزأيه دون الآخر مخطىء لأنه مركب منهما معاً، والناظر فيهما مصيب إذا قسط لكل واحد منهما قسطاً من نظره، وجعل له نصيباً من سعيه، على قدر استحقاق كل واحد منهما، ويحسب رتبته من الشرف والضعة.
أما الناظرون بحسب الجزء الطبيعي فإنهم انحطوا في جانب الطبيعة،
وانصرفوا بجميع قوتهم إليها، وجعلوا غايتهم القصوى عندها؛ ولذلك جعلوا
العقل آلة في تحصيل أسبابها وحاجاتهم، فاستعبدوا أشرف جزأيهم لأخسهما كمن
يستخدم الملك عبده.
وأما الناظرون بحسب الجزء العقلي فإنهم أغفلوا النظر في أحد جزأيهم الذي
هو طبيعي لهم، ونظروا نظراً إلهياً فطمعوا - وهم ناس مركبون - أن ينفردوا
بفضيلة العقل غير مشوب بنقص الطبيعة، فاضطروا لأجل ذلك إلى إهمال الجسد
وهو مقرون بهم، والضرورة تدعو إلى مقيماته من المصالح، أو إلى إزاحة علته
في حاجاته وهي كثيرة، فظلموا أنفسهم، وظلموا أبناء جنسهم.
أما ظلمهم لأنفسهم فتركوا النظر لأحد قسميهم الذي به قوامهم حتى التمسوا
مصالحها بتعب آخرين، فظلموهم بترك المعاونة إياهم، والعدل بأمر بمعونة من
يسترفد معونته، والتعب لمن يأخذ ثمرة تعبه.
وبهذه المعاونة تتم المدينة، ويصلح معاش الإنسان الذي هو مدني بالطبع
وهؤلاء هم الذين تسموا بالزهاد، وهم طبقات، وفي الفلاسفة منهم قوم، وفي
أهل الأديان والمذاهب والأهواء منهم طوائف، وفي شريعتنا الإسلام منهم قوم
وسموا أنفسهم بالصوفية، وقال منهم قوم بتحريم المكاسب.
وإذ قد بينا غلط الناظر في أحد جزأيه دون الآخر فلنذكر المذهب الصحيح الذي
هو الناظر في الجزأين معاً، وإعطاء كل واحد منهما قسطه طبيعية وعقلاً
فنقول: إن الإنسان كما ذكرناه هو مركب من هاتين القوتين، لا قوام له إلا
بهما فيجب أن يكون سعيه نحو الطبيعي منهما، والعقلي معاً.
أما السعي الطبيعي فغاية الإنسان فيه حفظ الصحة على بدنه والاعتدال على
مزاج طبائعه؛ لتصدر الأفعال عنه تامة غير ناقصة وذلك بالتماس المآكل
والمشارب والنوم واليقظة والحركة والسكون، والاعتدال في جميع ذلك، إلى
سائر ما يتضل بها من الملبس والمسكن الدافعين أذى القر والحر، والأشياء
الضرورية للبدن، ولا يلتمس غاية سواها، أعني التلذذ والاستكثار من قدر
الحاجة لطلب المباهاة، واتباع النهمة والحرص وغيرهما من الأمراض التي توهم
أن غاية الإنسان هي تلك.
وأما سعيه العقلي فغايته فيه أيضاً حفظ الصحة على النفس لأنها ذات قوى.
ولها أمراض بتزيد هذه القوى بعضها بعض، وحفظ الاعتدال هو طبها، والاستكثار
من معلوماتها هو قوتها، وسبب بقائها السرمدي، وسعادتها الأزلية.
وفي شرح كل واحد من هذه الفضائل طول، وهذا القدر من الإيماء كاف.
فليكن الإنسان ساعياً نحو هذين الجزأين بما يصلح كل واحد منهما، وليحفظ
على نفسه الاعتدال فيهما من غير إفراط ولا تفريط؛ فإنه حينئذ كامل فاضل،
لا يجد عليه أحد مطعناً إلا سفيه لا يكترث له أو جاهل لا يعبأ به، وبالله
التوفيق.
مسألة طبيعية ما السبب في اشتياق الإنسان إلى ما مضى من عمره
حتى إنه ليحن حنين الإبل، ويبكي بكاء المتململ، ويطول فكره بتخيله ما سلف؟ وبهذا المعنى هتف الشاعر فقال:لم أبك من زمن ذممت صروفه ... إلا بكيت عليه حين يزول
وقال الآخر:
رب يوم بكيت منه فلما ... صرت في غيره بكيت عليه.
وقال الآخر:
وأرجو غدا فإذا ما أتى ... بكيت على أمسه الذاهب.
هذا العارض يعترى إن كان الماضي من الزمان في ضيق وحاجة، وكرب وشدة، وما ذاك كذاك إلا لسر للنفس الإنسان غير شاعر به، ولا واجد له إلا إذا طال فحصه، وزال نقصه، واشتد في طلب تشميره، واتصل في اقتباس الحكمة رواحه وبكوره، وكانت الكلمة الحسناء أشرف عنده من الجارية العذراء، والمعنى المقوم أحب إليه من المال المكوم، وعلى قدر عنايته يحظى بشرف الدارين، ويتحلى بزينة المحلين.
الجواب: قال أبو مسكويه - رحمه الله - ليس يشتاق إلى الشباب والصبا إلا أحد رجلين: إما فاقد شهواته ولذاته التي سورتها وحدتها وقت الشباب.
وإما فاقد صحته في السمع والبصر، أو بعض أعضائه التي قوتها ووفورها زمن الصبا وحين الحداثة.
والمعنى الأول أكثر ما يتشوق، فإن المكتهل والمجتمع ومن بلغ الأشد الذي لا ينكر شيئاً من حواسه - يتشوق إلى الصبا، والشيخ لا يعدم من نفسه ورأيه وعقله شيئاً مما كان يجده في شبابه، واللهم إلا أن يهرم ويلحقه الخرف، فحينئذ لا يذكر بشيء من التشوق، ولا يوصف به، ولا يحتج برأيه.
وههنا سبب ثالث يشوق إلى الصبا وهو أن الأمل حينئذ في البقاء
قوي، وكأن الإنسان ينتظر أمامه حياة طويلة فكلما مضى منها زمان تيقن أنه
من أمده المضروب، وعمره المقسوم، فاشتاق إلى أن يستأنف به، طمعاً في
البقاء السرمدي الذي لا سبيل للجسد الفاني إليه.
إلا المعنى الأول هو الذي ذهب إليه الشعراء فأكثروا فيه، وقد صرحوا به
وذكروه في أشعارهم.
والمتشوق إلى شهواته صورته عند الحكماء صورة من أعتق فاشتاق إلى الرق، أو
صورة من أفلت من سباع ضارية كانت مقرونة به فاشتاق إلى معاودتها.
وذلك أن الشاب تهيم به قوى الطبيعة عنده الشهوة وعند الغضب حتى تغمر عقله
فلا يستشير لبه، ولا يكاد يظهر أثر العقل عليه إلا ضعيفاً.
وقد بينا فيما تقدم من المسائل أن فضيلة الإنسان وشرفه في الجزء الألهي
منه، وإن كان الجزء الآخر ضرورياً له.
فقد بان أن السن التي تضعف فيها قوى الطبيعة حتى يقتدر عليها العقل
فيزمها، ويجرها ذليلة طائعة غير متأبية ولا هائجة - أفضل الأسنان، والرجل
الفاضل الصالح لا يشتاق من أشرف أسنانه إلى أخسها.
والدليل البين على أن الأمر على ما حكيناه - أن الشاب العفيف الضابط
لنفسه، القوى على قمع شهواته مسرور بسيرته، وإن كان في جهد عظيم، ومحكوم
له بالفضل، مشهود له به عند جميع أهل العقل، وأنه إذا كبر وأسن لم يشتق
إلى الشباب؛ لأن ضبطه لنفسه، وقمعه لشهواته أيسر عليه وأهون.
ومن كان فلسفي الطريق، شريعي المذهب لم تعرض له هذه العوارض - أعنى التلهف
على نيل اللذات، والأسف على ما يفوته منها، والندم على ما ترك وقصر فيها -
بل يعلم أن تلك انفعالات خسيسة تقتضي أفعالاً دنيئة، وأن الحكماء - رضى
الله عنهم - قد بينوا رذائلها، وسطروا الكتب في ذمها، وأن الأنبياء -
صلوات الله عليهم - قد نهوا عنها، وحذروا منها، وكتب الله - تعالى وتقدس -
ناطقة بجميع ذلك، مصدقة له.
فأي شوق يحدث للفاضل إلى النقص، وللعالم إلى الجهل، وللصحيح إلى المرض؟
وإنما تلك أعراض تعرض للجهال الذين غايتهم الانهماك في الطبيعة والحواس،
وطلب ملاذها الكاذبة، لا التماس الصحة، ولا بلوغ السعادة، ولا تكميل
الفضيلة الإنسانية، ولا معتبر بهؤلاء ولا التفات إلى أقوالهم وأفعالهم.
مسألة خلقية لم اقترن العجب بالعالم
والعلم يوجب خلاف ذلك من التواضع والرقة، وتحقير النفس، والزراية عليها بالعجز؟ الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله - أما العالم المستحق لهذه السمة فليس يلحقه العجب، ولا يبلي بهذه الآفة وكيف يبلي بها وهو يعرف سببها، وأنها مرض سببه مكاذبة النفس؟ وذلك أن حقيقة العجب هي ظن الإنسان بنفسه من الفضل ما ليس فيه، وظنه هذا كذب، ثم يستشعره حتى يصدق به، فتكون صورته صورة من يرى رجلاً في الحرب شجاعاً يحمل على الأبطال، ويظهر فضيلة شجاعته فيكفي العدو، ويفنى القرن، وهذا الرأي عنه بمعزل، ناكص على عقبيه، ناء بجانبه، وهو ذاك يدعي تلك الشجاعة لنفسه، فهو يكذبها في الدعوى، ثم يصير مصدقاً بها، وهذا من أعجب آفات النفس وأكاذيبها؛ لأجل أن الكذب فيه مركب، فقد يكذب الإنسان غيره ليصدقه الغير فيموه نفسه عليه، فأما أن يموه نفسه بالكذب، ثم يصدق فيه نفسه فهو موضع العجب والعجب.ولأجل هذا التركيب الذي عرض في الكذب صار أشنع وأقبح من الكذب نفسه البسيط المعروف.
وإذا كان العالم الفاضل لا تقترن به آفة الكذب البسيط لمعرفته بقبحه لا سيما إذا استغنى عنه - فهو من الآفة المركبة أبعد.
فلذلك قلت: إن العالم لا يعجب، فقد صارت هذه المسألة مردودة غير مقبولة.
فأما ما يعرض من العجب لمن يظن أنه عالم فليس من المسألة في شيء.
مسألة ما سبب الحياء من القبيح مرة
؟وما سبب التبجح به مرة
؟وما الحياء أولاً؛ فإن في تحديده ما يقرب من البغية، ويسهل درك الحق؟ وما ضمير قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الحياء شعبة من الإيمان.
فقد قال بعض العلماء: كيف يكون الحياء - وهو من آثار الطبيعة - شعبة من الإيمان والإيمان فعل؟ يدلك آمن يؤمن إيماناً، وهناك تقول حيى الرجل واستحيي، فيصير من باب الانفعال، أى المطاوعة.
وهل يحمد الحياء في كل موضع أم هو موقوف على شأن دون شأن، ومقبول في حال دون حال؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما الحياء الذي أحببت
أن نبدأ به فحقيقته انحصار نفس مخافة فعل قبيح يصدر عنها.
وهو خلق مرضى في الأحداث؛ فإنه يدل على أن نفسه قد شعرت بالشيء القبيح،
وأشفقت من مواقعته، وكرهت ظهوره منه، فعرض لنفسه هذا العارض.
وإحساس النفس بالأفعال القبيحة، ونفورها عنها دليل على كرم جوهرها ومطمع
في استصلاحها جداً.
قال صاحب الكتاب في تدبير المنزل: ليس يوجد في الصبي فراسة أصح ، ولا دليل
أصدق لمن آثر أن يعرف نجابته وفلاحه وقبوله الأدب - من الحياء.
وذلك لما ذكرناه من علة الحياء، وبيناه من أمره.
فأما المشايخ فلا يجب أن يعرض لهم هذا العارض؛ لأنه لا ينبغي لهم أن
يحذروا وقوع فعل قبيح منهم؛ لما سبق من علمهم ودربتهم، ومعرفتهم بمواضع
القبيح والحسن، ولأن نفوسهم يجب أن تكون قد تهذبت وأمنت وقوع شيء قبيح
منهم؛ فلذلك لا ينبغي أن يعرض لهم الحياء.
وقد بين الحكيم هذا في كتاب الأخلاق.
فقد ذكرنا الحياء ما هو وأنه انفعال، وأنه يحسن بالأحداث خاصة، وذكر سبب
حسنه فيهم.
فأما المسألة عن سبب التبجح بالقبيح فمسألة غير لازمة؛ لأن هذا العارض
سببه الجهل بالقبيح، وليس يعرض إلا للجهال من الناس، والدليل على ذلك أنهم
إذا عرفوا القبيح أنه قبيح اعتذروا منه، وتركوا التبجح به.
وإنما يتبجح حين لا يعلم وجه قبحه، وهو في تلك الحالإذا تبجح به خرج له
وجهاً مموهاً في الحسن، فيصير تبجحه بالحسن الذي خرجه أوموه به، فإذا تيقن
أنه قبيح، أو ليس يتموه وجه الحسن فيه - عدل عنه، واستحيى منه، وترك
التبجح به.
فأما قولة عليه السلام: الحياء شعبة من الإيمان فكلام في غاية الحسن
والصحة والصدق، وكيف لا يكون شعبة منه وإنما الإيمان التصديق بالله عز
وجل، والمصدق به مصدق بصفاته وأفعاله التي هي من الحسن في غاية لا يجوز أن
يكون فيها وفي درجتها شيء من المستحسنات؛ لأنها هي سبب حسن كل حسن وهي
التي تفيض بالحسن على غيرها؛ إذ كانت معدنه ومبدأه، وإنما نالت الأشياء
كلها الحسن والجمال والبهاء منها وبها.
وكذلك جميع أوامر الله - تعالى - وشرائعه، وموجبات العقل الذي هو رسوله
الأول، ووكيله - عند جميع خلقه - الأقدم.
ومن عرف الحسن عرف ضده لا محالة، ومن عرف ضده حذره وأشفق منه، فعرض له
الحياء الذي حررناه ولخصناه.
وصديقك أبو عثمان يقول: الحياء لباس سابغ، وحجاب واق، وستر من المساوىء.
أخو العفاف، وحليف الدين، ومصاحب بالتصنع، ورقيب من العصمة، وعين كالئة،
يذود عن الفساد، وينهى عن الفحشاء والأدناس.
وإنما حكيت لك ألفاظه لشغفك به، وحسن قبولك كل ما يشير إليه، ويدل عليه.
مسألة طبيعية ما سبب من يدعى العلم
وهو يعلم أنه لا علم عنده؟ وما الذي يحمله على الدعوى، ويدينه من المكابرة، ويحوجه إلى السفه والمهاترة؟.الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: سبب ذلك محبة الإنسان نفسه، وشعوره بموضع الفضيلة، فهو لأجل المحبة يدعى لها ما ليس لها؛ لأن صورة النفس التي بها تحسن، وعليها تحصل ومن أجلها تسعد - هي العلوم والمعارف، وإذا عريت منها أو من جلها حصلت له من المقابح ووجوه الشقاء بحسب ما يفوتها من ذلك.
ومن شأن المحبة أن تغطي المساوىء، وتظهر المحاسن إن كانت موجودة، وتدعيها إن كانت معدومة، فإن كان هذا من فعل المحبة معلوماً، وكانت النفس محبوبة لا محالة، عرض لصاحبها عارض المحبة، فلم ينكر ادعاء الإنسان لها المعارف التي هي فضائلها ومحاسنها وإن لم يكن عندها شيء من ذلك؟.
مسألة طبيعية ما سبب فرح الإنسان بخبر ينسب إليه
وهو فيه؟ وما سبب سروره بجميل يذكر به وليس فيه؟.الجواب: عن هذه المسألة هو الجواب عن المسألة التي قبلها؛ لأن الخير المختص بالنفس هو العلوم الصحيحة، والأفعال الصادرة بحسبها عنها.
فإذا اعترف الإنسان بأن نفسه فاضلة خيره، وجب أن يسر لمحبوبه وقد شهد له بالجمال والحسن؛ فلذلك يسر إن ذكر بجميل ليس فيه للعلة التي ذكرناها في المسألة الأولى.
مسألة اختيارية لم قبح الثناء في الوجه حتى تواطئوا على تزييفه
؟ولم حسن في المغيب حتى تمنى ذلك بكل معنى، ألأن الثناء في الوجه أشبه الملق والخديعة؟ وفي المغيب أشبه الإخلاص والتكرمة أم لغير ذلك؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: لما كان الثناء في
الوجه على الأكثر إعارة شهادة بفضائل النفس، وخديعة الإنسان بهذه الشهادة،
حتى صار ذلك - لاغتراره وتركه كثيراً من الاجتهاد في تحصيل الفضائل، وغرض
فاعل ذلك احتراز مودة صاحبه إلى نفسه بإظهار مودته له، ومحبته إياه - صار
كالمكر والحيلة فذم وعيب.
فأما في المغيب فإنما حسن لأن قصد المثنى في الأكثر الاعتراف بفضائل غيره،
والصدق عنه فيها.
وفي ذلك تنبيه على مكان الفضل، وبعث للموصوف والمستمع على الازدياد
والإتمام، وحض على أسبابه وعلله.
وربما كان القصد خلاف ذلك، أعني أن يكون غرض المثنى في المغيب مخادعة
المثنى عليه، والطمع في أن يبلغه ذلك عنه فيتنفق عليه، ويستميله، ويستجر
به منافعه وهو حينئذ شبيه بالحالة الأولى في المكر، ومستقبح.
وربما قصد الأول في الثناء والمدح في الوجه الصدق لا الملق، فيصير
مستحسناً إلا بقدر ما يظن أن الممدوح يغتر به فيقصر في الاجتهاد.
فقد تبين أن الثناء يحسن بحسب قصد المثنى وأغراضه، وبحسب صدقه فيه وكذبه،
وعلى قدر استصلاحه للمثنى عليه أو استفساده، ولكن الأمر محمول على الغائب
في الظن والعادة فيه.
ولما كان الأمر على الأكثر كما ذكرناه، وعلى ما حكيناه - قبح في البوه،
وحسن في المغيب، وإن جاز أن يقع بالضد فيحسن في الوجه ويقبح في المغيب.
مسألة طبيعية لم أحب الإنسان أن يعرف ما جرى
من ذكره بعد قيامه من مجلسه
حتى إنه ليحن إلى أن يقف على ما يؤبن به بعد وفاته، ويحب أن يطلع على حقيقة ما يكون ويقال؟ وكيف لم يتصنع لفعل ما يحب أن يكون منسوباً إليه مزيناً به؟ هذا ومحبته لذلك طبيعة لو رام زواله عنها لما أطاق ذاك، وإن كابر طباعه، وأراد خداعه.الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد تقدم لنا في بعض هذه الأجوبة التي مضت أن للنفس قوتين: إحداهما هي التي بها يشتاق الإنسان إلى المعارف واستثباتها، ولما كانت هذه المعرفة عامة له في سائر الأشياء كانت بما يخصه في نفسه التي هي محبوبته ومعشوقته - أولى.
فالإنسان يشتاق إلى هذه المعرفة بالطبع الأول، والقوة التي هي ذاتية للنفس، ثم يتزيد هذا التشوق، ويشتعل ويقوى؛ لأجل اختصاصه بمعرفة أحوال نفسه المحبوبة.
فأما تصنعه لفعل ما يحب أن يكون منسوباً إليه فإنه ليس يتركه إلا أن يعترضه عارض آخر من شهوة عاجلة تقاومه، فهي أغلب وأشد مجاذبة له كما ضربنا به المثل فيما تقدم من علم المريض بحفظ الصحة، وحاجته إليها، ثم إيثاره عليها نيل شهوة دنية عاجلة، وإن فاتته الصحة المؤثرة في العاقبه.
ولولا هذه الشهوات الدنية المعترضة على السعادات المؤثرة - ما تميز الفاضل من الناقص، ولا مدح العفيف، وذم النهم - ، وكنا حينئذ لا ننتفع بالآداب والمواعظ، وكان لا يحسن منا التعب والرياضة فيما على الطبيعة فيه كلفه ومشقة.
وهذا بين كاف في جواب المسألة.
مسألة اختيارية قال لم حمق الشاب إذا تشايخ
وأخذ نفسه بالزماته والمتانة، وآثر الجد واقشعر من الهزل، ونبا عن الخنا، وسدد طرفه في مشيه، وجمع عطفه في قعوده، وشقق في لفظه، وحدق في لحظه؟.الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: السبب في ذلك أن الشاب إذا تشايخ فإنما يظهر أن لا حركة لطبيعته نحو الشهوات، وهذه القوة والطبيعة هي في الشباب على غاية التمام والتزايد؛ لأنها في حال النشوء، ولا تزال متزيدة إلى أن تبلغ غايتها، وتقف، ثم تنتقص على رسم سائر قوى الطبيعة، فإذا ادعى الشاب مرتبة الشيخ التي قد انحطت فيها هذه القوة علم أنه كاذب فاستقبح منه الكذب والرياء في غير موضعه، ومن غير حاجة إليه.
والكذب إذا كان صراحاً وغير خفي، وكان صاحبه يأتيه من حاجة إليه ازداد مقت الناس له، واستبدل به على رداءة جوهر النفس.
فإن اتفق لهذا الشاب أن يكون صادقاً، أعني أن تكون طبيعته ناقصة، وشهوته خامدة - استدل على نقصان طبائعه، وبرىء من عيب الكذب، إلا أن يكون مرحوماً لأجل نقص بعض طبائعه عما فطر عليه الناس، ويصير بالجملة غير مذموم، ولا معيب إذا كان صادقاً.
وأما إن كان صادقاً في ضبط نفسه مع حداثة سنه، والتهاب شهواته،
ومنازعة قواه إلى ارتكاب اللذات، فإن مثل هذا الإنسان لا يلبث أن يشتهر
أمره، ويعظم ذكره، ويصير إماماً معصوماً، أو نبياً مبعوثاً، أو ولياً
مستخلصاً.
وليس يخفى على الناس المتصفحين حركات الصادق من حركات الكاذب، وأفعال
المتصنع من أفعال المطبوع.
على أن هذا الشاب الصادق الذي استثنينا به إنما يوجد في القرانات الكبيرة
والأزمنة المتفاوتة، والأكثر هو ما قدمنا الكلام فيه، فلذلك سبق الناس
إليه بالحكم عليه.
فأما المسألة التالية لهذه وهي قولك: وعلى هذا لم سخف شيخ تفتى وحرك
منكبيه، وحضر مجالس اللهو، وطلب سماع الغناء، وآثر الخلاعة، وأحب المجون؟
وما المجون والخلاعة حسب ما جرى ذكرها؟.
فإن الجواب عنها شبيه الأولى؛ لأنها عكسها وذلك أن الشيخ إذا ادعى تزيد
قوى طبيعته في حال الشيخوخة لم يخل من كذب يمقت عليه - لا سيما وكذبه إنما
هو في ادعاء شرور ونقصانات كان ينبغي له، ولو كانت موجودة له، أن بجحدها -
أو صدق يوبخ عليه إذا لم يقهر هذه القوة الغالبة عليه في الزمان الطويل
الذي مد له فيه، ويتنبه في مثله على الفضائل، ويتمكن فيه من رياضة النفس،
واستكمال التأديب، فحاله أقبح من حال الشاب الذي سبق الكلام فيه؛ ولذلك هو
أمقت وأقبح صورة عند ذوي العقول.
فأما المجون فهو المسارعة إلى فعل ما تستدعيه النفس الشهوانية من غير
مشاورة للعقل، ولا مراقبة للناس.
وأما الخلاعة فاشتقاقه من خلع العذار الذي يضبط به العقل أفعاله.
ولفظة العقل شبيهة بذلك؛ لأنه من العقال.
وكذلك الحجر.
مسألة خلقية لم خص اللئيم بالحلم
؟وخص الجواد بالحدة
؟وهل يجتمع الحلم والجود، وهل تقترن الحدة واللؤم؟ وما حكمهما في الأغلب، فإن الثابت على وجه غير المتقلب إلى وجه.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أظنك أردت بالبخيل اللئيم؟ وبينهما فروق.
وقد تكلمت على مرادك لأن باقي الكلام يدل عليه.
فلعمري إن ذلك في الأكثر كذلك وإن كان قد ينعكس الأمر فيوجد حليم جواد، وبخيل حديد، إلا أن الأولى أن يكون الجواد حديداً، وذلك أن البخيل هو الذي يمنع الحق من مستحقيه على ما ينبغي، وفي الوقت الذي ينبغي، وكما ينبغي، فإذا منه البخيل الحق على الوجوه التي ذكرت صار ظالماً، وإذا أحس بهذه الرذيلة من نفسه وجب أن يصبر على المتظلمين وهم الذامون؛ لأنه من البين أن البخيل إذا ذمه الذام فإنما يذكره مواقع ظلمه، وإخراج الحق الذي عليه على غير الوجوه التي تنبغي.
وإذا كان الذام صادقاً والبخيل يعرف صدقه بما يجده من نفسه، فيجب أن يحلم لا محالة؛ لموافقته الصدق، ولأن النفس بالطبع تسكن عند الصدق، وتستخذي له، فالأشبه بالنظام الطبيعي أن يكون البخيل حلما لما ذكرناه وربما عرض ضد ذلك، وهو إذا كان البخيل جاهلاً بالحقوق التي تجب عليه على الشرائط التي ذكرناها، فإذا جهل ذلك لم يعرف صدق من يصدقه عنه، ولا ظلمه وإنصافه، وفيعرف قبح أفعاله، فتعرض له رذيلتان: إحداهما منع الحق،والأخرى الجهل بموضع الحق، فربما عرض للجاهل الحدة والنزق، والعدول عن الحلم، لما ذكرناه، وأخبرنا السبب فيه.
فأما قولك: لم خص الجواد بالحدة فمسألة غير مقبولة؛ لأن الجواد ليس يختص بالحدة؛ وذلك أن حقيقة الجود هو بذل ما ينبغي فيالوقت الذي ينبغي على ما ينبغي، ومن كانت له هذه الفضيلة لم ينسب إلى الحدة؛ لأن الحديد لا يميز هذه المواضع، فهو يتجاوز حد الجواد، وإذا تجاوزه سمى مسرفاً ومبذراً، ولم يستحق اسم المدح بالجود.
ولكن لما كانت لغة العرب وعادتها مشهورة في وضع الجود موضع السرف والتبذير حتى إذا كان الإنسان في غاية منهما كان عندهم أشد استحقاقاً لاسم الجود - خفي عليهم موضع الفضيلة، ومكان المدح، وصارت الحدة المقترنة بالمبذر والمسرف على حسب موضوعهم محمودة؛ لأنها لا تمكن من الروية، فيبادر صاحبها إلى وضع الشيء في غير موضعه فيسمى مسرفاً عند الحكاء.
وقد تبين في كتب الأخلاق أن الجود الذي هو فضيلة وسط بين طرفين مذمومين: أحدهما تقصير، والآخر غلو.
فأما جانب التقصير من الجود فهو الذي يسمى البخل، وهو مذموم، وأما الجانب الذي يلي الغلو فهو الذي يسمى السرف.
والواجب على من أحب استقصاء ذلك أن يقرأه من كتب الأخلاق فإنها
تستغرق شرحه.
مسألة طبيعية واختيارية لم كان الإنسان محتاجاً إلى أن يتعلم العلم؟
ولا يحتاج إلى أن يتعلم الجهل، ألأنه في الأصل يوجد جاهلاً؟ فما علة ذلك؟
فبإثارة علته يتم الدليل على صحته.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد تبين في المباحث الفلسفية أن
العلم هو إدراك النفس صور الموجودات على حقائقها، ولما قال بعض الأوائل:
إن النفس مكان للصورة استحسنه أفلاطون، وصوب قائله؛ لأن النفس إذا اشتاقت
إلى العلم الذي هو غايتها نقلت صورة المعلوم إلى ذاتها حتى تكون الصورة
التي تحصلها مطابقة لصورة المنقول منه، لا يفضل عليها، ولا ينقص منها، وهو
حينئذ علم محض.
وإن كانت الصورة المنقولة إلى النفس غير مطابقة للمنقول فليس بعلم.
وهذه الصورة كلما كثرت عند النفس قويت على استثبات غيرها والنفس في هذا
المعنى كالمناصب للجسد؛ وذلك أن الجسد إذا حصلت فيه صورة ضعف عن قبول صورة
غيرها، إلا بأن تنمحي الصورة الأولى منه، أو تتركب الصورة الأولى والثانية
الواردة فتختلط الصورتان ولا تحصلان ولا إحداهما على التمام، وليست النفس
كذلك.
ولما كانت نفس الإنسان هيولانية مشتاقة إلى الكلام الموضوع لها بأن يتصور
بصورة الموجودات كلها، أعني الأمور الكلية دون الجزئية، وكانت قوية على
ذلك، وكانت صورة الموجودات فيها غير مضيفة بعضها مكان بعض، بل هي بالضد من
الأجسام في أنها كلما استثبتت صورة في ذاتها قويت على استثبات أخرى، وخلصت
الصور كلها بعضها من بعض وذلك بلا نهاية - كان الإنسان محتاجاً إلى تعلم
العلم أي إلى استثبات صور الموجودات، وتحصيلها عنده.
فأما الجهل فاسم لعدم هذه الصور والمعلومات، ونحن في اقتناء هذه الصور
محتاجون إلى تكلف واحتمال مشقة وتعب إلى أن تحصل لنا.
فأما عدمها فليس مما يتكلف ويتجشم، بل النفس عادمة لذلك.
ومثل ذلك من المحسوس صورة لوح لا كتابة فيه، وإثبات الكتابة، وصور الحروف
يكون بتكلف، فأما تركه بحاله فلا كلفه فيه، إلا على مذهب من يرى صور
الأشياء موجودة للنفس بالذات، وإنما عرض لها النسيان، وان العلم تذكر
وإزالة لآفة النسيان عن النفس.
ولو كان الأمر كذلك لكان جواب المسألة بحسب هذا المذهب بيناً في أن التعب
بإزالة آفة واجب، وتركه مأووفاً لا تعب فيه.
ولكن هذا المذهب غير مرغوب فيه، والشغل به في هذا الموضع فضل؛ لأنه ليس من
المسألة في شيء، وإن كان الكلام قد جر إليه، ولكنا ندل على موضعه فليؤخذ
من هناك، وهو كتب النفس.
فقد تبين أن العلم تصور النفس بصورة المعلوم، والتصور تفعل من الصورة.
والجهل هو عدم الصورة، فكيف يستعمل التفعل من الصورة في عدم الصورة؟ هذا
محال.
مسألة طبيعية لم شارك المعجب من نفسه المتعجب منه
؟مثال ذلك: شاعر يفلق في قافية فيتعجب منه السامع حسب ما اقتضى بديعه، فالشاعر لم يتعجب أيضاً؛ وهو المتعجب منه؟ وهذا نجده في النظم والنثر، والجواب والكتاب والحساب والصناعة.
وعلى ذكر التعجب ما التعجب؟ وعلى ماذا يدل؟ فقد قال ناس فيه كلاماً: قل لبعض الحكماء:ما أعجب الأشياء؟ قال:السماء بكوا كبها.
وقال آخر: أعجب الأشياء النار.
وقال الآخر: أعجب الأشياء لسان الناطق.
وقال الآخر: أعجب الأشياء العقل اللاحق.
وقال الآخر: الشمس.
قال أرسسططاليس: أعجب الأشياء ما لم يعرف سببه.
وقال الآخر: بل أعجب الأشياء الجهل بعلة الشيء.
فعلى قياد ما قال أولئك كل شيء عجب.
وعلى ما وضع ما قال هذا الحكيم كل مجهول سببه، فهو عجب، كان ذلك من الحقير، أو من النفيس.
وقال آخر: أعجب الأشياء الرزق؛ فإن مناطه بعيد، وغوره عميق، والعقل مع شرفه فيه جيران، والعاقل مع اجتهاده سكران.
وقال آخر: لا عجب.
وصدق.
فما هذا التفاوت والتباين، وليس في الحق اختلاف، ولا في الباطل ائتلاف؟ وعلى ذكر الحق والباطل، ما الحق والباطل؟ وينتظم في هذا الفصل.
قال بعض الأولين: أعجب الأشياء إكداء الوافر، ومنال العاجز.
وقال آخر من الصوفية: - وشاهدته وناظرته واستفدت منه - أعجب الأشياء بعيد لا يجحد، وقريب لا يشهد، وهو الحق الأحد.
وعلى ذكر الله تعالى، بم يحيط العلم من المشار إليه باختلاف
الإشارات والعبارات؟ أهو شيء يلتصق بالاعتقاد؟ أم هو مطلق لفظ بالاصطلاح؟
أم هو إيماء إلى صفة من الصفات مه الجهل بالموصوف؟ أم هو غير منسوب إلى
شيء بعرفان؟ فإن كان منعوتاً بنعت، فقد حصره الناعت بالنعت.
وإن كان غير منعوت، فقد استباحه الجهل، وزاحمه المعدوم.
ولا بد من الإثبات إذا إستحال النفي، وإذا وقف الإثبات والنفى على المثبت
النافي، فقد سبق إذن كل إثبات ونفى.
فإن كان سابقاً كل هذه الألفاظ، وجميع هذه الأغراض، فما نصيب العارف؟ وما
بغية ما ظفر به الموحد؟ هيهات! هيهات! اشتد الغلط، ورجع كل إلى الشطط،
وفات الله الفهم والفاهم، والوهم والواهم، وبقي مع الخلق علم مختلف فيه،
وجهل مصطلح عليه، وأمر قد تبرم به، ونهى قد ضجر منه: وحاجة فاضحة، وحجة
داحضة؛ وقول مزوق، ولفظ منمق، وعاجل معشق، وآجل معوق، وظاهر ملفق، وباطن
ممزق.
إلى الله الشكوى من غلبات الهوى، وسطوات البلوى؛ إنه رحيم ودود.
الجواب: قال أبو مسكويه - رحمه الله: هذه المسألة التي ذنب فيها صاحبها
بمسائل أعظم منها، وأبعد غورا، وأشد اعتياصاً، وأصابه فيها ما كان أصابه
قبل في مسألة تقدمها، فظهر لي في عذره أنه داء يعتريه، ومرض يلحقه، وليس
من طغيان القلم، ولا سلاطة الهذر، ولا أشر الاقتدار في شيء، كما أنه ليس
من جنس ما يستخف المتكهن عند الكهانة، ولا من نمط ما يعترى المتواجد من
الصوفية، وما أحسبه إلا من قبيل المس والخبل والطائف من الشيطان الذي
يتعوذ بالله منه، فلقد أطلق في سجاعته القافية بما تسد له الآذان، وتصرف
عنه الأبصار والأذهان.
ولولا أنه اشتكى إلى الله تعالى في آخرها من سطوات البلوى فاعترف بالآفة،
واستحق الرأفة، لكان لي في مداواته، شغل عن تسطير جواباته.
إفهم - عافاك الله - أن أثار النفس وأفعالها كلها بديعة عند الحس وأصحابه،
ولذلك تجد أكثر الناس متعجبين من النفس نفسها، ومتحيرين فيها، ظانين بها
ضروب الظنون، وليس يخلون مع كثرة تفننهم في هذه الظنون من أن يجعلوها
جسماً على عاداتهم في الحس، وتصورهم في المحسوسات، ثم يجدون أفعال هذه
النفس وآثارها غير مشبهة شيئاً من آثار الجسم وأفعاله، فيزداد تعجبهم، ولو
أنهم حصلوا مائية النفس لكان تعجبهم من آثارها أقل؛ إذ كانت هي غير جسم،
ولو صح لهم أنها جسم لم يكن بديعاً عندهم أن تكون آثارها غير جسمانية.
ولما كان الشاعر المفلق، والناظر في المسألة العويصة مكن الحساب وغيره من
الصناعات - إنما يستدعي نظراً نفسانياً، ووجوداً عقلياً، ويحرك نفسه حركة
غير مكانية؛ ليظفر بمطلوب غير جسماني، ثم وجد هذه الحركة من النفس مفضية
بالإدمان والإمعان إلى وجود المطلوب - عجب هو أولاً من هذه الحركة التي
يجدها من نفسه ضرورة، وليست مكانية على عادة الجسم في حركة الجسم، ثم من
وجوده المطلوب بعقب هذه الحركة.
عرض له هذا العارض من التعجب ولم يكن السامع أولى بهذا التعجب منه؛ لأنهما
قد اشتركا في الجهل بالنفس، وبآثارهما وأفعالهما، وكل واحد منهما حقيق
بالتعجب.
فأما العارف بالنفس وجوهرها، العالم أنها ليست بجسم، وأن آثارها وأفعالها
لا يجب أن تكون جسمانية - فإنه لا يعترض له هذا العارضفي نفسه، وكذلك صورة
مستمعة إذا كان عالماً كعلمه.
فأما التعجب نفسه الذي سأل عنه السائل في عرض مسألته الأولى فإنه حيرة
تعرض الإنسان عند جهل السبب، فكلما كانت المعرفة بأسباب الموجودات أقل
كانت المجهولات أكثر، والتعجب بحسبها أشد، وبالضد إذا كانت المعرفة بأسباب
الموجودات أكثر، كانت المجهولات أقل، والتعجب بحسبها أقل؛ ولذلك قال قوم:
كل شيء عجب.
وقال قوم: لا عجب من شيء.
فإن كانت الطائفة الأولى اعترفوا بالجهل العام، وزعموا أنهم يجهلون أسباب
الأمور، فالطائفة الثانية ادعت لنفسها مزية عظيمة؛ لأنهم زعموا أنهم
يعرفون أسباب الأمور.
فأما قولك - أعزك الله - عندما عددت أقوال المتكلمين في التعجب -
ما هذا التفاوت والتباين وليس في الحق اختلاف، ولا في الباطل ائتلاف؟
فالجواب: أن التعجب ليس بشيء له طبيعة، ولا وجود له من خارج وإنما هو كما
ذكرنا النفس عند جهلها السبب، ولما كان ما يجهله زيد قد يعلمه عمرو، ولم
ينكر تفاوتهما في العجب؛ لأن كل واحد منهما متعجب مما يجهل سببه، ومجهول
هذا هو بعينه معلوم هذا.
وإنما كانت تكون المسألة عويصة وبديعة لو كان لأمر ما وجود من خارج ثم
اختلف فيه قوم فضلاء يعتد بآرائهم، ويذكر تباينهم، وقال قوم منهم: هو حق،
وقال آخرون: هو باطل.
على أن مثل هذا قد وقع في مسألة الخلاف، وفي الزمان والمكان والعدم
وأشباهها من المسائل، فقال قوم: هي جواهر لا أجسام لها، وقال قوم: هي
أعراض، وقال آخرون: ليست أجساماً ولا جواهر ولا أعراضاً.
واحتج كل قوم بحجج قوية.
إلا أن جميع هذه المذاهب تحررت في زمان الحكيم، واستقر قرارها، ووضح
مشكلها، وبان صحيحها من سقيمها.
وليس من شأننا الإطالة في هذه المسائل، فنذكرها ونحكيها.
فإن أحببت معرفتها فقف عليها من مظانها، وجرد لها مسائل لنفرد لها زماناً
ونظراً، إن شاء الله.
وأما سؤالك في آخر هذه المسألة: بم يحيط على الخلق من المشار إليه بقولنا
الله باختلاف الإشارات والعبارات؟ مع سائر ما ذكرت، فغير معترف بشيء منه،
ولا يقول أحد إنه يحيط علمه بشيء من هذا، ولا يلصق به كما ذكرت، ولا يعترف
أيضاً بهذه النعوت فيه.
والكلام في هذا الموضوع لا يمكن استقصاؤه؛ إذ كان جميع سعى الحكماء
بالفلسفة إنما ينتهى إلى هذا، وإياه قصد بالنظر كله، وليس يمكن أن يتكلم
فيه إلا بعد جميع المقدمات التي قدمت له ومهدت لأجله، أعنى الرياضيات
والطبيعيات، ثم ما بعد الطبيعة من علم النفس والعقل، ثم بعد معرفة جميع
هذه الجواهر الشريفة يمكن أن يعلم أنها محتاجة ناقصة متكثرة مضطرة إلى سبب
أولى، وموجد قديم، ومبدع ليس كهي في ذات ولا صفة فيكون هذا الجهل أشرف من
كل علم سبقه، وهو من الصعوبة والغموض بحيث تراه.
ولو كان إلى معرفة هذا الموضع طريق غير ما ذكرناه لسلكه القدماء وأهل
الحرص على إشاعة الحكمة وإذاعتها، فإنهم - رضى الله عنهم - ما أسفوا ولا
بخلوا، ولكن لم يجدوا إلى هذا المطلوب إلا طريقاً واحداً فسلكوه وسهلوه
بغاية جهدهم، ودلوا عليه، وأرشدوا عليه، وهو غاية سعادة البشر، فمن اشتاق
إليه فليتكلف الصبر على سلوك الطريق إليه صعباً كان أو سهلاً، وطويلاً كان
أم قصيراً، على عادة المشتاق فإنه يسلك السبيل إلى الظفر بمحبوبه كيف
كانت، غير مفكر في الوعورة والبعد.
ومن لم يعط الصبر على هذا السلوك فليقنع برخص الألفاظ والصفات المطلقة له
في الشرائع الصادقة المعتادة، وليصدق الحكماء والأنبياء والمقتدين بهم،
وليحسن الظن، فليس يجد غير هذين الطريقين.
والله ولى المعونة والتوفيق.
مسألة اختيارية لم اشتد الأنس واستحكم
والتحمت الزلفة، وطال العهد - سقط التقرب، وسمج الثناء؟ ومن أجله قيل: إذا قدم الإخاء سقط الثناء.وهذا عيانة مشهود، وخبره موجود.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن الثناء في الوجه وغير الوجه إنما هو إعطاء المثنى عليه حقوقه من أوصافه الجميلة، والاعتراف بها له، وإعلامه أن المثنى قد شعر بها، وأوجبها له، وسلمها إليه؛ ليصير ذلك له قربة ووسيلة، ولتحدث بينهما المودة والمشاكلة، وليستجلب الود، وتستحكم المعرفة.
فإذا حصلت هذه الأمور في نفس كل واحد منهما، وعلم المثنى عليه أن المثنى قد أنصفه، وسلم إليه حقه، واعترف له بفضله، ولم يبخسه ماله، وحدثت المودة والمحبة التي هي نتيجة الإنصاف، وثمرة العدل، وقدمت هذه الحال، وأتى عليها الزمان - سمج تكلف إظهار ذلك ثانياً؛ لذهاب الغرض الأول، وحصول الثمرة المطلوبة بالسعى الأول.
وتكلف مثل هذا عبث وسفه، مع ما فيه من إيهام ضعف اليقين الثناء الأول، وأنه احتاج إلى تطرية وتجديد شهادة؛ لأن الشهادة الأولى كانت زوراً، وظناً مرجماً.
وهذا توهين لعقد المودة التي شهد لها في المسألة بشدة الأسر، واستحكام الأصل، ووثاقة السبب.
مسألة طبيعية لما صار الأعمى يجد فائته من البصر
في شيء آخر
؟كمن نجده من العميان من يكون ندى الحلق، طيب الصوت، غزير العلم،
سريع الحفظ، كثير الباه، طويل التمتع، قليل الهم.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن للنفس خمسة مشاعر تستقي منها
العلوم إلى ذاتها، وكأنها في المثل منافذ وأبواب لها إلى الأمور الخارجة
عنها.
أو مثل أصحاب أخبار يردون إليها أخبار خمس نواح.
وهي متقسمة القوة إلى هذه الأشياء الخمسة.
ومثالها أيضاً في ذلك مثال عين ماء ينقسم ما ينبع منها إلى خمسة أنهار في
خمسة أوجه مختلفة.
أو مثال شجرة لها خمس شعب، وقوتها منقسمة إليها.
وقد علم أن هذه العين متى سد مجرى ماء أحد أنهارها توفر على أحد الأنهار
الأربعة الباقية أو انقسم فيها بالسواء، أو على الأقل والأكثر منها، وليس
يغور ذلك القسط من ماء النهر المسدود، ولا يغيض، ولا يضيع.
وكذلك الشجرة إذا قطعت شعبة من شعبها صار الغذاء الذي كان ينصرف إليها من
أصول الشجرة وعروقها - متوفراً على شعبها الأربع الباقية؛ حتى تبين في
ساقها وورقها وأغصانها، وفي زهرها وحبها وثمرها، وقدعرف الفلاحون ذلك،
وأصحاب الكروم، فإنهم يقضبون من الشجر الشعب والأغصان التي تستمد الغذاء
الكثير من الأصول؛ ليتوفر على الباقي فيصير ثمراً ينتفعون به.
وكذلك صنيعتهم في الأشجار التي لا تثمر إذا أحبوا أن تغلظ ساق واحدة منها،
وتستوى في الانتصاب ويسرع نموها كأشجار السرو والعرعر والدلب وأشباهها مما
يحتاج إلى خشبه بالقطع والنحت والنجر، فإنهم يتأملون أي الأغصان أولى بأن
ينبت مستوياً غير مضطرب، وأيها أحق بالأصل الذي يمده بالغذاء فيبقونه،
ويحذفون الباقي فينشأ ذلك الغصن في أسرع زمان وأقصر مدة؛ لأنصراف جميع
الغذاء إليه.
وإذا كان هذا ظاهراً من فعل الطبيعة، فكذلك حال الأعمى في أن إحدى قوى
نفسه التي كانت تنصرف إلى مراعاة حس من حواسه لما قطعت عن مجراها توفرت
النفس بها إما على جهة واحدة، أو جهات موزعة، فتبينت الزيادة، وظهرت إما
في الذهن والذكاء أو الفكر، أو الحفظ، أو غيرها من قوى النفس.
وهذا يبين لك أيضاً باعتبار الحيوانات الأخر؛ فإن منها ما هو في أصل
الخلقة وبالطبع مضرور في أحد حواسه، أو فاقد له جملة، وهو في الباقيات
منها أذكى من غيره جداً كالحال في الخلد؛ فإنه لما فقد آلة البصر كان أذكى
شيء سمعاً، وكالحال في النحل، فإنه لما ضعف بصره كان أدهى من المبصرات
شماً.
وأنت تعرف ضعف بصر النحل والنمل والجراد والزنانير وما أشبهها من
الحيوانات التي لا تطرف ولم تخلق لها جفون، وعلى أبصارها غشاء صلب حجري
يدفع عنها الآفات - بما يعرض لها في البيوت التي لها جامات الزجاج؛ فإن
أحدها يظن أن الجام كوة نافذة إلى الهواء فلا يزال يصدمه إرادة للخروج إلى
أن يهلك.
فأما صدق شمه فهو ظاهر بما يقصده من المشمومات عن المسافة البعيدة جداً.
فأما تمتع الأعمى بالباه، وقلة الهم، فإن سببه أيضاً فقد النفس إحدى
آلاتها التي كانت تقتطعه عن هذه الأشياء بمراعاتها، فإذا انصرفت إلى الفكر
في شيء آخر قوى فعلها فيه.
ولما كانت الاهتمامات بالمبصرات كثيرة، ودواعي النفس إلى اقتنائها شديدة
كالملبوسات وأصنافها، والمفروشات وأنواعها، والمتنزهات وألوانها، وبالجملة
جميع المدركات بالبصر - ثم فقدته، انقطعت عن أكثر الأشياء التي هي هموم
الإنسان، وأسبابه في الفكر، واستخراج الحيل في تحصيلها وقت الطمع فيها،
وأسفه على فوتها إذا فاتته، فتقل هموم الأعمى لأجل ذلك.
مسألة طبيعية واختيارية لم قال الناس لا خير في الشركة
؟وهذا نجده ظاهر الصحة؛ لأنا ما رأينا ملكاً ثبت، ولا أمراتم، ولا عقداً صح بشركة، وحتى قال الله - عز ذكره - " بسم الله الرحمن الرحيم " لو كان آلهة إلا الله لفسدتا " صدق الله العظيم " وصار هذا المعنى أشرف دليل في توحيد الله - جل ثناؤه - ونفى كل ما عداه.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إنما صارت الشركة بهذه الصفة لأن كل من استغنى بنفسه، وكفته قوته في تناول حاجته لم يستعن فيها بغيره، فإذا عجز واحتاج إلى معاونة غيره اعترف بالنقص، واستمد قوة غيره في تمام مطلوبه.
ولما كان العجز مذموماً، والنقص معيباً كانت الشركة التي سببها العجز والنقص معيبة مذمومة؛ لأنه يستدل بها على نقص المتشاركين جميعاً وعجزهما.
على أن الشركة للإنسان ليست مذمومة في جميع أحواله، بل إنما تذم
في الأشياء التي قد يستقل بها غيره، وينفرد باحتمالها سواه، كالكتابة وما
أشبهها من الصناعات التي لها أجزاء كثيرة، وقد يجمعها إنسان واحد فيستقل
بها، وينفرد بالصناعة أجمعها، فإذا نقص فيها آخر واحتاج إلى الإستعانة
بغيره ظهر نقصه، وبان عجزه، ودخل في صناعته خلل.
أو كاحتمال مائة رطل من الثقل، فإن الإنسان الواحد يكمل له، ويستقل به،
فإذا احتاج إلى غيره في احتماله دل على نقصه وعجزه وخوره.
ثم يعرض في الأمر المشترك فيه من النقص والتفاوت لأجل القوى المختلفة،
والهمم المتباينة، والأغراض المتضادة التي قد تعاورته - ما لا يعرض في
غيره من الأمور التي ينفرد بها ذو القوة الواحدة، وتخلص فيها همة واحدة،
ويختصها غرض واحد؛ فإن مثل هذا ينتظم ويتسق، ويظهر فيه فضل بين على الأول.
فأما الأمور التي لا يكمل الإنسان الواحد لها، ولا يستقل بها أحد، فإن
الشركة واجبة فيها، كاحتمال حجر الرحى، ومد السفن الكبار وغيرها من
الصناعات التي تتم بالجماعات الكثيرة، وبالشركة والمعاونة؛ فإن هذه
الأشياء وإن كانت الشركة فيها واجبة؛ لعجز البشر، وكان الذم ساقطاً،
ومصروفاً عن أصحابها بما وضح من عذرهم فيها - فإن المعلوم من أحوالها أنها
لو ارتفعت بقوة واحدة، وتمت بمدبر واحد كانت لا محالة أحسن انتظاماً، وأقل
اضطراباً وفساداً، وأولى بالصلاح وحسن المرجوع.
فالشركة بالإطلاق دالة على عجز الشريكين، وعائدة بعد على الأمر المشترك
فيه بالخلل والفساد عما يتم بالتفرد، وإن كان البشر معذورين في بعضها وغير
معذورين في بعض.
وأما الملك البشري فإنه لما كان من الأمور التي تنتظم بتدبير واحد، وأمر
واحد - وإن اشتركت فيه الجماعة فإنهم يصدرون عن رأي واحد، ويصيرون كآلات
للملك، فتتآحد الكثرة، ويظهر النظام الحسن - كان الاستبداد والتفرد به
أفضل لا محالة، كما مثلناه فيما تقدم.
فإذا اختلفت الجماعة التي تتعاون فيه، ولم تصدر عن رأي واحد ظهر فيه من
الخلل والوهن والتفاوت ما يظهر في غيره باختلاف الهمم، وانتشار الكثرة
المؤدي إلى فساد النظام المتآحد، ثم يكون فساد أعم وأظهر ضرراً بحسب غنائه
وعائدته وعظم محله وجلالة موضعه.
وقد أبان الله - تعالى - جميع ذلك بأخصر لفظ وأوجز كلام وأظهر معنى، وأوضح
دلالة في قوله عز من قائل " بسم الرحمن الرحيم " لو كان فيهما آلهة إلا
الله لفسدتا " صدق الله العظيم " سبحانه وجل ثناؤه ولا إله غيره.
مسألة اختيارية لم فزع الناس إلى الوسائط في الأمور
مع ما قالوه في المسألة الأولى من فساد الشركة والشركاء
؟حتى إن جماهير الأمور ومعاظم الأحوال، في الشريعة والسياسة، لا تتم ولا تنتظم إلا بوسيط يلحم ويسدي، ويرتق ويفتق، ويحسن ويجمل.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: لما كانت ضرورات الناس داعية إلى شركة الأحوال التي قدمنا ذكرها في المسألة الأولى، وكان كل إنسان يحب نفسه، ويحب لها المنفعة، ويحرص على الاستئثار بها دون صاحبه - ظهر الفساد، وحدث التظالم الذي ذكرته في المسألة المقدمة، ولم يثق أحد المشاركين في الأمر بصاحبه؛ لأنه ذو نصيب فيه، ومحبة للمنفعة العائدة منه لنفسه، وكان للهوى تطرق إليه، وتسلق عليه فاحتاجا إلى واسطة تكون حاله في ذلك الأمر برية من حالهما؛ ليعتدل حكمه، ويصح رأيه، ويعطى كل واحد قسطه ونصيبه من غير حيف ولا هوى.
وليس يجب إذا كانت الشركة مذمومة أن يخلو منها الإنسان؛ لأنه يضطر بالضعف البشري إليها كما ضربنا له المثل من الحمل الثقيل، أو كثرة أجزاء الشيء المنظور فيه.
فإن تركت الشركة في مثل هذه الأمور، وأهملت المعاونة، فات ذلك الأمر دفعة، وفي فوته فوت منافع عظام، فكان تحصيله على ما يقع فيه من الخلل أولى من تركه رأساً.
وأكثر أمور البشر لا يتم إلا بالمعاونة والتشارك؛ لعجزهم عن التفرد، ونقصهم عن الكمال، وظهور أثر الخلق والإبداع فيهم، فلما كان المتشاركون في الأمر أكثر عددا، والآراء أشد اختلافاً، والأهواء أغمض مدخلاً - كانت الحاجات إلى الوسائط أصدق، والضرورة إليهم أشد.
والسياسة من هذه الأمور، أعني التي تكثر فيها الأهواء، ويحتاج فيها إلى الإشتراك والتعاون فيحتاج فيه إلى من يصدق رأيه، ويسلم من الهوى والعصبية، فإن أمكن أن يكون الوسيط خلوا من ذلك الأمر كان أجدر بالحكم العدل، والرأى الصائب، وإن لم يكن ذلك اجتهد أن يكون حظه في الأمر أقل من حظ المختصمين، أو يكون أكثر ضبطاً للنفس، وأقمع للهوى، وأكثر رياضة من غيره، وكل ذلك ليسلم من داعي الهوى، والميل معه، والانصباب إليه؛ لتتفق الكلمة، ويحدث العدل الذي هو سبب التآحد وزوال الكثرة.
مسألة طبيعية خلقية لم طال لسان الإنسان في حاجة غيره
إذا عنى به، وقصر لسانه في حاجته مع عنايته بنفسه؟ وما السر في هذا؟.الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: بنية الإنسان وتركيبه ومبدأ خلقه وقه على أنه ملك، فكل إنسان له أن يكون ملكاً بما أعد له من القوى المساعدة عليه، ولا ينبغي لأحد أن يقصر عن أحد في هذا المعنى إلا لآفة أو نقص في البنية.
ولما عرض للواحد بعد الواحد أن يسأل غيره، مع أن موضوعه موضوع الآخر، ولم يكن بأن يحتاج إلى صاحبه أولى من أن يحتاج صاحبه إليه - وجب أن تحدث له عزة نفس تمنعه من التذلل.
ولهذه العلة وجب التمدن، وحدث الاجتماع والتعاون، وحسن بين الناس التعامل، وأن يدفع الإنسان إلى صاحبه حاجته إذا كانت عنده؛ ليستدعي مثلها منه، فيجدها أيضاً عنده.
فالسائل إذا لم يكن معوضاً ولا معاملاً، والتمس الرفد من غيره من غير مقابلة عليه، ولا وعد من نفسه بمثله - كان كالظالم، وأيسر ما فيه أنه قد حط نفسه عن رتبة خلق عليها، وندب إليها فقصر لسانه، واحتقر نفسه.
فأما إذا تكلم في حاجة غيره لم يعرض له هذا العارض، فكأنه إنما يحيل بهذا النقص على من تكلم عنه فانطلق لسانه، ولم تذل نفسه.
مسألة طبيعية خلقية ما سبب الصيت
الذي يتفق لبعضهم بعد موته، وأنه يعيش خاملاً، ويشتهر ميتاً كمعروف الكرخي؟ الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: معظم السبب في ذلك الحسد الذي يعتري أكثر الناس، لا سيما إذا كان المحسود قريب المنزلة من الحاسد، أو كان في درجته من النسب أو الولاية والبلدية أو ما أشبهها؛ فإن هذه النسب إذا تقاربت بين الناس فاشتركوا فيها، ثم انفرد واحد منهم بفضيلة نافسه الباقون فيها، وحسدوه إياها حتى يحملهم الأمر على أن يجحدوه آخر الأمر؛ ولذلك قيل: أزهد الناس في عالم جيرانه؛ لأن الجوار وكثرة الاختلاط سبب جامع لهم يتساوون فيه؛ فإذا انفرد أحدهم بفضيلة لحق الباقين ما ذكرته.وربما كان سبب زهدهم فيه غير هذا، ولكن الأغلب ما ذكرته.
فأما البعيد الأجنبي فإنه لما لم يجمعه وإياه سبب خف عليه تسليم الفضل له، وقل عارض الحسد فيه؛ لأجل ذلك إذا مات المحسود، وانقطع السبب الذي بينه وبين الحساد أنشئوا يفضلونه، ويسلمون له ما منعوه إياه في حياته.
مسألة خلقية ما الحسد الذي يعترى الفاضل العاقل
من نظيره في الفضل، مع علمه بشناعة الحسد، وبقبح اسمه، واجتماع الأولين والآخرين على ذمه؟ وإن كان هذا العارض لا فكاك لصاحبه منه لأنه داخل عليه، فما وجه ذمه والإنحاء عليه؟ وإن كان مما لا يدخل عليه ولكنه ينشئه في نفسه، ويضيق صدره باجتلابه، فما هذا الإختيار؟ وهل يكون من هذا وصفه في درجة الكلمة أو قريباً من العقلاء؟ وقد قيل لأرسططاليس: ما بال الحسود أطول الناس غماً؟ قال: لأنه يغتم كما يغتم الناس، ثم ينفرد بالهم على ما ينال الناس من الخير.الجواب: قال أبو على مسكويه - رحمه الله: الحسد أمر مذموم، ومرض للنفس قبيح، وقد غلط فيه الناس حتى سموا غيره باسمه مما ليس يجرى مجراه.
وهذا بعينه هو الذي غلط السائل حتى قال: ما الحسد الذي يعترى الفاضل؟ لأن من يكون فاضلاً لا يكون حسداً.
وسنتكلم على الحسد ما هو؛ لتعرف مائيته فيعرف قبحه، ويوضع في موضعه، ولا يخلط بغيره، فنقول: إن الحسد هو غم يلحق الإنسان بسبب خير نال مستحقه، ثم يتبع هذا الانفعال الرىء أفعال أخر رديئة، فمنها أن يتمنى زوال ذلك الخير عن المستحق، ويتبع هذا التمنى أن يسعى فيه بضروب الفساد فيتأدى إلى شرور كثيرة.
فمن عرض له عارض الحسد الذي حددناه فهو شرير، والشرير لا يكون فاضلاً.
ولكن لما كان هذا الغم قد يعرض الإنسان على وجوه أخر غير مذمومة
غلط فيه الناس فسموه باسم الحسد، ومثال ذلك أن الفاضل قد يغتم بالخير إذا
ناله غير مستحقه، لأنه يؤثر أن تقع الأشياء مواقعها، ولأن الخير إذا حصل
عند الشرير استعمله في الشر إن كان مما يستعمل، أو لم ينتفع به بتة.
وربما اغتنم الفاضل لنفسه إذا لم يصب من الخير ما أصابه غيره إذا كان
مستحقاً مثله.
وإنما لما اسم هذا حسداً لأن غمه لم يكن بالخير الذي أصاب غيره، بل لأنه
حرم مثله.
وإذا آثر لنفسه ما يجده لغيره لم يكن قبيحاً، بل يجب لكل أحد إذا رأى
خيراً عند غيره أن يتمناه أيضاً لنفسه، لأن هذا الغم لا يتبعه أن يتمنى
زوال الخير عن مستحقه.
وقد فرقت العرب هذين: فسموا أحدهما حاسداً، والآخر غابطاً.
ونحن نؤدب أولادنا بأن ندلهم على الأدباء ونندبهم على فضائلهم، فإن ذا
الطبع الجيد منهم يتمنى لنفسه مثل حال الفاضل، ويسلك سبيله، ويجتهد في أن
يحصل له ما حصل للفاضل، وبهذه الطريقة ينتفع أكثر الأحداث.
وأما ذو الطبع الردىء فإنه يغتم بما حصل لغيره من الأدب والفضل، ولا يسعى
في تحصيل مثله لنفسه، ولكنه يجتهد في إزالته عن غيره، أو منعه منه، أو
يججده إياه، أو يعيبه به فهو حينئذ حاسد شرير!!! فأما قولك إن هذا العارض
لا فكاك لصاحبه منه لأنه داخل عليه إلى آخر الفصل فإني أقول: إن
الانفعالات - أعني ما لا يكن نحو الاستكمال - كلها مذمومة؛ لأنها من قبيل
الهيولى، ولذلك لو أمكن الإنسان ألا ينفعل بتة لكان أفضل له، ولكن لما لم
يكن إلى ذلك سبيل وجب عليه أن يزيل كل ما أمكن إزالته من الانفعالات؛ ليتم
ويكمل، وذلك بالأخلاق والآداب المرضية، ويحصل له ذلك بسياسة الوالدين
أولاً، ثم بسياسة السلطان، ثم بسياسة الناموس والآداب الموضوعة لذلك؛ فإن
الإنسان يستفيد بهذه الأشياء صوراً وأحوالاً، ثم تصير قنية وملكة، وهي
المسماة فضائل وآداباً.
مسألة طبيعية خلقية ما سبب الجزع من الموت
؟وما الاسترسال إلى الموت؟ وإن كان المعنى الأول أكثر فإن الثاني أبين وأظهر.
وأي المعنيين أجل: الجزع منه أم الاسترسال إليه؟ فإن الكلام في هذه الفصول كثير الريع جم الفوائد.
الجواب: قال أبو على مسكويه - رحمه الله: الجزع من الموت على ضروب، وكذلك الاسترسال إليه.
وبعضه محمود، وبعضه مذموم؛ وذلك أن من الحياة ما هو جيد محبوب، ومنها ما هو ردىء مكروه، فيجب من ذلك أن يكون ضدها الذي هو الموت بحسبه: منه ما هو حيال الحياة الجيدة المحبوبة، فهو ردىء مكروه، ومنه ما هو حيال الحياة الرديئة المكروهة، فهو جيد محبوب.
ولا بد من تبيين هذه الأقسام ليبين سبب الجزع والاسترسال، وأيهما أعلى، فأقول: إن الحياة المقترنة بالآفات العظيمة، والمهن الهائلة، والآلام الشديدة: مثل أن يسبي الرجل وأهله وولده ويملكهم قوم أشرار حتى يرى في أهله وولده ما لا طاقة له به، ويسام في نفسه وجسمه ما لا صبر عليه، ويقع في الأمراض الشديدة التي لا برء منها، ويضطر إلى فعل قبيح بأصدقائه وبوالديه، فهذا كله ردىء مكروه، وليس أحد يختار العيش فيه، ولا يؤثر الحياة معه، فضده إذا جيد محبوب؛ لأن الموت أمام هذه المحن في مجاهدة عدو يسوم هذا السوم - موت مختار جيد.
فيجب بحسب هذا النظر أن نقول: إن تلك الحياة المكروهة يستحب فيها الموت الذي هي ضده، فالاسترسال إلى هذا الموت جيد، وسببه ظاهر.
وكذلك إذا عكست الحال، فإن الحياة المحبوبة والعيش المضبوط، التي معها صحة البدن، واعتدال المزاج، ووجود الكفاية من الوجوه الجميلة، والتمكن بهذه الأشياء من السعي نحو السعادة القصوى، وتحصيل الصورة المكملة للإنسان مع مساعدة الإخوان الفضلاء، وقرة العين بالأولاد النجباء، والعز بالعشيرة وأهل بيت الصالحين - كله محبوب مؤثر جيد.
ومقابله إذن الذي هو الموت ردىء مكروه؛ لأن الموت ينقطع به استكمال السعادة وإتمام الفضيلة، ويفوته أمراً عظيماً كان معرضاً له.
فالجزع من هذا الموت واجب، وسببه بين.
وهذا ضرب من النظر، وباب من الاعتبار.
وضرب آخر وهو أن البقاء بنفسه أمر مختار؛ لأنه وجود متصل، والوجود كريم شريف.
وضده العدم رذل خسيس، والرغبة في الشيء الكريم واجبة، كما أن الزهد في الشيء الخسيس واجب.
وإذا كانت حياة ما منقطعة لا محالة، ثم كان ذلك يفضي إلى حياة
أخرى أبدية، ووجود سرمدي - صار هذا الموت غير مكروه إلا بقدر ما يكره من
الدواء المر إذا أدى إلى الصحة، فإن العلاج المؤلم والدواء الكريه مختاران
إذا أديا إلى صحة طويلة، وسلامة متصلة.
فإن لم يكونا مختارين بالذات فهما مختاران بالعرض.
فالإنسان المستبصر الذي يرى أن أخراه أفضل من دنياه، وآجله خير له من
عاجله - يسترسل إلى الموت استرساله إلى الدواء الكريه، والعلاج المؤلم؛
ليفضي به إلى خير دائم، وإن كان هذا الأختيار بالعرض لا بالذات، وربما ظن
ذلك ظناً فحسن أيضاً منه الاسترسال إليه بحسب قوة ظنه وما وقع إقناعه به،
كما يحسن في الدواء إذا قوى ظنه بمعرفة واصفه له.
فأما من خلا من هذا الاعتقاد والظن القوي فهو يجزع من الموت؛ لأنه عدم ما،
والعدم مهروب منه، وهذا سبب صحيح وعلة ظاهرة.
وهذا ضرب آخر من الاسترسال إلى الموت، والجزع منه، وهو أن من قوى ظنه
واستحكمت بصيرته في عاقبته ومعاده ولكنه لم يقدم ما يعتقد أنه يسعد به،
ولم يتأهب بأهبته، ولا استعد له عدة، فهو يكره الموت، ويجزع منه، ولا
يسترسل إليه.
وبالضد من راى أنه مستعد لعدته، آخذ أهبته، فهو حريص عليه، مسترسل إليه.
وأنت ترى ذلك في أصحاب الأهواء المختلفة، والديانات المتضادة، كالهند في
تسرعهم إلى إحراق نفوسهم، وإقدامهم على ضروب المثل والقتل في أبدانهم،
وكالخوارج في حرصهم على الموت، وبذلهم نفوسهم في مواقفهم المشهورة،
وحروبهم المأثورة، وأن الرجل إذا طعن قنع فرسه ليسبح في الرمح، وينتهي إلى
طاعنه، ثم قرأ: " بسم الله الرحمن الرحيم " وعجلت إليك رب لترضى " صدق
الله العظيم " ؛ ولذلك اتخذ أصحاب السلطان في صدور رماحهم حاجزاً لئلا
يسبح فيها المطعون فيصل إلى الطاعن.
والصابرون على أنواع العذاب، وضروب المثل والقتل من أهل الأهواء - أكثر من
أن يحصوا.
وإنما ذكرنا سبب الجزع من الموت، والاسترسال إلى الموت، وأيهما يحسن، وفي
أي موضع، وعلى أي حال.
مسألة طبيعية لم كانت النجابة في النحاف أكثر
؟ولم كانت الفسولة في السمان أكثر
؟الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذه المسألة كأنها عن الحال الأغلب، والوجود الأكثر.
والسبب فيه أنه لما كانت الحرارة الغريزية سبب الحياة، وسبب الفضائل التابعة للحياة، أعنى الذكاء والحركة والشجاعة وما أشبهها - كانت الأبدان التي حظها منها أكثر - أفضل.
والحكم الصحيح في هذا أن الأبدان المعتدلة في النحافة والسمن، والطول والقصر، وسائر الكيفيات الأخر - أفضل الأبدان.
ولما كانت مسألتك مخصوصة بالنحافة والسمن خصصنا الجواب أيضاً، فنقول: إن الحرارة إذا قاومت أخلاط البدن فأذابت فضول الرطوبات منه، ونفت البرد الغالب عليه هو ضده - كان ذلك سبباً للحركة واليقظة، وسبباً للإقدام والنجدة.
ويتبع هذه الأشياء سائر الفضائل اللازمة لها، وذكو الحرارة التي في القلب، وهي أول هذه الفضائل كلها.
وإذا غلبت الرطوبات عليها أطفأتها وغمرتها، وحالت بينها وبين أفعالها، وعاقتها عنها، فكان ذلك سبباً للفسولة ولواحقها من الكسل والبلادة والجبن وسائر الرذائل التي تتبعها.
والنحافة والسمن، وإن كانا جميعاً قد خرجا عن الإعتدال، فأحدهما وهو النحافة خروجه عن الاعتدال بإفراط الحرارة التي هي سبب الفضائل، وهي أولى بها من اطرف الأخر الذي ضدها، اعني السمن الذي هو خروج عن الاعتدال إلى جانب البرد وعدم الحرارة المؤدي إلى بطلانها وزوالها.
وقد تبين في كتاب الأخلاق أن أطراف الفضائل كلها مذمومة، ولكن بعضها أقرب إلى المدح.
وإن كان البعد من الوسط فيهما واحداً كان الاعتدال الممدوح بالجود والسخاء له طرفان، أحدهما البخل، والآخر التبذير، وهما جميعاً مذمومان، وخارجان من الاعتدال، إلا أن أحد الطرفين، وهو التبذير أشبه بالجود من الطرف الآخر؛ لأن أحد الطرفين بالإمعان يتأدى إلى بطلان الشيء الممدوح وعدمه، والآخر يتأدى إلى الزيادة فيه بالإفراط.
ولعمري إنهما في فقد الاعتدال سواء ولكن أحدهما أشبه به من الآخر.
وهذا هو موضع لا يدفع ولا ينكر.
مسألة طبيعية لم كان القصير أخبث، والطويل أهوج؟.
الجواب: قال أبو على مسكويه - رحمه الله: هذا أيضاً طرفان لموضع
الفضيلة، وذلك أن الاعتدال من الطول والقصر هو المحمود، ولكن الطول
بالتفاوت في الخلق أقرب إلى الذم، وذلك لبعد الأعضاء الرئيسية بعضها من
بعض، لا سيما العضوان اللذان هما أظهر الأعضاء رياسة، أعني القلب والدماغ،
فإن هذين يجب أن يكون بينهما مسافة معتدلة؛ لتتمكن الحرارة التي في القلب
من تعديل برودة الدماغ، وحفظ اعتداله، وبقاء الروح النفساني الذي يتهذب في
بطون الدماغ، وتتمكن أيضاً برودة الدماغ من تعديل حرارة القلب، وحفظ
اعتداله عليه.
وهذا الاعتدال إذا بعد أحد العضوين من الآخر تفاوت واضطرب نظامه، وفسد
التركيب، وفسدت الأفعال الصادرة عن الإنسان، ونقصت فضائله.
وليس يعرض في قرب التفاوت ما يعرض في بعد أحدهما من الآخر.
مسألة خلقية لم صار بعض الناس إذا سئل عن عمره نقص
في الخبر، وآخر يزيد على عمره في الخبر؟.الجواب: قال أبو علي بن مسكويه - رحمه الله: غلاض الرجلين أعني الناقص من مدة عمره، والزائد فيها - غرض واحد وإن اختلفا في الخبر.
وربما فعل الرجل الواحد ذلك بحسب زمانين مختلفين، أو بحسب حالين في زمان واحد.
وهو من رذائل الأخلاق؛ لأنه يوهم بالكذب فضيلة لنفسه ليست فيها.
وسبب هذا الفعل محبة النفس، وذاك أن الإنسان يحب أن يعتقد فيه من الفضل أكثر مما هو، ويحب أن يعذر في نقص إن وجد فيه.
وهو إذا كان حدثاً وظهرت منه فضيلة أو نقيصة نقص من زمان عمره، ليعلم غيره أن الفضيلة حصلت له في زمان قصير، وأن ذلك لم يكن ليتم له إلا بعناية كثيرة، وحرض شديد، ونفس كريمة، وانصراف عن الشهوات الغالبة على أقرانه، وترك اللعب الذي هو يستولى على لداته، وكلما كان الزمان أقصر كان إلى الفضيلة أقرب، وكان التعجب منه أكثر.
وإن كانت منه نقيصه عذر في فعله بقلة الحنكة والدربة،وانتظر فلاحه ورجى تلافيه وإنابته.
وإن الإنسان مرشح طول عمره لاقتناء الفضائل، والاستكثار من المعارف، ويجب أن يكون أبداً بحال من الفضل يستكثر في مثل سنه أن يبلغ إليها، أو يعجب من كثرة تدربه بالزمان القصير في الأمور التي يحتاج فيها إلى الزمان الطويل.
وأيضاً فإن المكتهل، وذا السن الكثير التجربة ممن صحب الزمان، ولقى الرجال، وتصرف في العلوم - مهيب في النفوس، جليل في الصدور، موقر في المجالس، مستشار في النوائب، مرجوع إليه في الرأي.
وهذه حال مرغوب فيها، فإذا بلغ الإنسان من السن ما يحتمل أن يدعي فيه هذه الدعوى أو يشبه نفسه بأصحاب هذه المراتب - زاد في عمره؛ لتسلم له هذه المرتبة فتعتقد فيه.
فكل واحد من الرجلين، أو الرجل الواحد في الزمانين أو الحالتين، غايته في التكذب بما ينقص من عمره التمويه بالفضل، وادعاء رتبة ليست له.
وهذا شر ظاهر فمتعاطيه شرير، وأفاضل الناس لا يعتريهم هذا الشر؛ لأنهم لا يتدنسون بالكذب، ولا يتكثرون بالباطل.
مسألة طبيعية لم صار الإنسان يحب شهراً بعينه، ويوماً بعينه؟
ومن أن يتولد للإنسان صورة يوم الجمعة على خلاف صورة يوم الخميس؟ وقيل للروذكي - وكان أكمه، وهو الذي ولد اعمى - كيف اللون عندك؟ قال: مثل الجمل.
الجواب: قال أبو على مسكويه - رحمه الله: أما محبة الإنسان شهراً بعينه فلأجل ما يتفق له فيه من شعادة ما، بحصول مأمول، أو ظفر بمطلوب، أو انتظار مرجو في وقت بعينه، أو سرور بعقب غم، أو راحة بعد تعب، وربما استمر ذلك به، وتكرر عليه مدة من عمره في وقت بعينه، فأنس به وألفه وأحبه لما يتفق له فيه، ولذلك أحب صبيان المسلمين يوم الجمعة، وألفوه بعد ذلك طول عمرهم، وكرهوا يوم السبت؛ لأن يوم الجمعة مفروض لهم فيه الراحة، مرخص لهم اللعب، ويتلوه يوم السبت الذي هو يوم تعبهم وعودهم إلى ما يكرهون من فقد اللعب.
فأما صبيان اليهود فإنما يعرض لهم ذلك في يوم السبت وما يليه، وصبيان النصارى في يوم الأحد وما يليه، وكذلك أيام الأعياد التي أطلق للناس فيها الراحة والزينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم " أيام أكل وشرب وبعال " .
وهذه الأيام مختلفة في أصحاب الملل.
وكل قوم يحبون الأيام التي هي أعيادهم التي أطلق لهم فيها الزينة والمتعة والراحة.
وأما من تساوت به الأحوال من الأمم التي ليست تحت شرع، ولا لهم
نظام في سيرتهم وأحوالهم، كالزنج وأواخر الترك وأشباههم، فليس يلحقهم هذا
المعنى، وليس يحبون يوماً بعينه، ولا شهراً، ولا وقتاً مخصوصاً.
فأما تولد صورة يوم الجمعة على خلاف صورة يوم الخميس فإنه على ما أقول: إن
الزمان الأظهر الأعم الأشهر هو ما تحدثه دورة واحدة من الفلك الأقصى، أعني
الذي يدبر جميع الأفلاك ويحركها بحركة نفسه إلى غير جهة حركاتها، وذلك من
المشرق إلى المغرب، من مفروضه إلى أن يعود إليها، وهو في أربع وعشرين ساعة.
وإنما صار هذا الزمان أظهر للناس لما يظهر فيه من صباح يعرض، ومساء بيوم
وليلة، وسببهما ظهور الشمس في بعض هذه المدة فوق الأرض، وغيبتها في بعض
تحت الأرض.
وتكرر هذه الأدوار هي الأيام والليالي.
وفي كل دور منها للناس أفعال وحركات ومواليد ومعاملات ليست في الدورة
الأخرى.
ويتعلق بأفعالهم هذه أحكام وأقضية في مدد معلومة، وآجال مفروضة، في مدة
مضروبة، يحتاجون فيها إلى نسبتها إلى دورة بعد دورة من الفلك الأقصى التي
هي سبب لكون اليوم والليلة؛ لتصح معاملاتهم، وتصدق قضاياهم، وتتعين آجالهم
المضروبة في أعمالهم ومعاملاتهم.
وههنا زمان آخر تحدثه دورة أخرى تختص بها الشمس في سيرها.
وذلك أن تبتدىء الشمس من نقطة مفروضة، وتعود إليها بعينها بحركة نفسها دون
تحريك المحرك الأول.
وهذه الدورة هي من المغرب إلى المشرق بخلاف تلك.
وتتم الدورة الواحدة من هذه الحركة التي تخص الشمس، في ثلاثمائة وخمسة
وستين يوماً وربع يوم على التقريب.
وهذا هو زمان أيضاً، ولكنه منسوب إلى حركة الشمس نفسها، ويسمى: سنة.
وههنا زمان آخر قد تعارفه الناس أيضاً، واشتهر بينهم، وظهوره وإن لم يكن
كظهور الشمس فهو تال له، وهو ما يكون ويحدث بدورة واحدة من حركة القمر
التي تخصه دون تحريك المحرك الأول.
وتتم الدورة الواحدة بهذه الحركة التي تخص القمر، وهي أيضاً من المغرب إلى
المشرق، في ثمانية وعشرين يوماً، ويسمى شهراً.
فهذه الأزمنة الثلاثة لما كانت ظاهرة مكشوفة تراها العيون؛ لأجل تعلقها
بالشمس والقمر اللذين هما أنور الكواكب وأبينها وأكبرها في الظاهر -
تعارفها الناس، وتعاملوا عليها، وحدثت صورة لكل دورة بحسب ما يقسطه الناس
في أعمالهم، وبحسب ما يفشو فيها ويحدث من الأعمار والمواليد وبحسب نسبة
حركاتهم إليها بمبدأ ومنتهى.
وإذا نظر الإنسان إلى هذه الأدوار في أنفسها خالية من حركات الناس
وأفعالهم، ولم ينسب إليها حركة أخرى، وفعلاً آخر - لم يكن بينها فرق بتة
إلا بالتكرر الذي لا بد فيه من العدد بالأول والثاني والثالث، وإلى حيث
انتهى الإحصاء.
فإن نظر فيها بحسب الأحوال، ونسب إليها أفعالاً وآثاراً، ونظمها بالحساب -
حدثت صور مختلفة بحسب اختلاف الأمور الواقعة فيها، المنسوبة إليها.
فأما الأكمه الذي ذكرته في المسألة، فإن الفاقد حاسة من حواسه لا يتصور
شيئاً من محسوساته؛ لأن التصور في النفس من كل محسوس إنما يقع بعد الإحساس
به.
وذلك أن هذه القوى من قوى النفس التي تأخذ العلوم من الحواس، إنما ترقيها
إلى قوة التخيل عن الحس، فحينئذ تثبت صورة المحسوس في القوة المتخيلة، وإن
زالت صورة الحس وغابت.
فأما إذا فقد الحس فكيف يترقى المحسوس إلى قوة التخيل؟ فبحق صار الأكمه لا
يتخيل شيئاً من الألوان ولا يتصوره.
وكذلك إن فقد فاقد حس الشم والسمع من مبدأ ولادته، لم يتخيل شيئاً من
محسوساتهما لما قدمناه.
وحدثني بعض أهل التحصيل من المتفلسفين أنه سأل رجلاً أكمه: كيف يتصور
البياض؟ فقال: حلو.
فكأنه لما لم يجد صورة البياض في تخيله ردها إلى حاسة أخرى هو واجد
لمحسوسها، فسماها بها، وظنها إياها.
مسألة في حد الظلم
ما معنى قول الشاعر: -والظلم في خلق النفوس فإن تجد ... ذا عفه فلعلة لا يظلم.
وما حد الظلم أولاً؟ فإن المتكلمين ينفكون في هذه المواضيع كثيراً، ولا ينصفون شيئاً، وكأنهم في الغضب والخصام.
وسمعت فلاناً في وزارته يقول: أنا أتلذذ بالظلم، فما هو هذا؟ ومن أين منشؤه أعني الظلم؟ أهو من فعل الإنسان، أم هو من آثار الطبيعة؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: الظلم انحراف العدل.
ولما احتيج في فهمه إلى فهم العدل، أفردنا له كلاماً ستقف عليه
ملخصاً مشروحاً.
وهو في معنى الجور الذي هو مصدر جار يجور، إلا أن الجور يستعمل في الطريق
وغيره إذا عدل فيه عن السمت، والظلم أخص بمقابلة العدل الذي يكون في
المعاملات، فالعدل من الاعتدال، وهو التقسيط بالسوية، وهذه السوية من
المساواة بين الأشياء الكثيرة، والمساواة هي التي توجد الكثرة، وتعطيها
الوجود، وتحفظ عليها النظام.
وبالعدل والمساواة تشيع المحبة بين الناس، وتأتلف نياتهم، وتعمر مدنهم،
وتتم معاملتهم، وتقوم سننهم.
ولشرح هذا الكلام، وتحقيق مائية القول في العدل وذكر أقسامه وخصائصه - بسط
كثير لم آمن طوله عليك، وخروجي فيه عن الشريطة التي اشترطتها في أول
الرسالة من الإيجاز، ولذلك أفردت فيه رسالة ستأتيك مقترنة بهذه المسألة،
على ما يشفيك بمعونة الله.
ولو أصبنا فيه كلاماً مستوفى لحكيم مشهور، أو كتاباً مؤلفاً مشروحاً -
لأرشدنا إليه على عادتنا، واحلنا عليه كرسمنا، ولكنا لم نعرف فيه إلا
رسالة لجالينوس مستخرجة من كلام أفلاطون، وليست كفاية في هذا المعنى،
وإنما هي حض على العدل، وتبيين لفضله، وأنه أمر مؤثر محبوب لنفسه.
وإذا عرفت العدل من تلك الرسالة، عرفت منه ما عدل عنه، ولم يقصد سمته.
وكما أن إصابة السهم من الغرض إنما هو نقطة منه، فأما الخطأ والعدول عنها
فكثير بلا نهاية - فكذلك العدل لما كان كالنقطة بين الأمور تقسمها
بالسوية، كانت جهات العدول عنها كثيرة بلا نهاية.
وعلى حسب القرب والبعد يكون ظهور القبح، وشناعة الظلم.
فأما قول الشاعر: والظلم في خلق النفوس فمعنى شعري لا يحتمل من النقد إلا
قدر ما يليق بصناعة الشعر.
ولو حملنا معاني الشعر على تصحيح الفلسفة، وتنقيح المنطق لقل سيمه، وانتهك
حريمه، وكنا مع ذلك ظالمين له بأكثر مما ظلم الشاعر النفوس التي زعم أن
الظلم في خلقها.
على أنا لو ذهبنا نحتج له، ونخرج تأويله لوجدنا مذهباً، وأصبنا مسلكاً
ولكن هذه الأجوبة مبينة على تحقيقات مغالطة الشعراء، ومذاهبهم، وعاداتهم
في صناعتهم.
ثم أقول: إن الظلم الذي ذكرنا حقيقته يجري مجرى غيره من سائر الأفعال، فإن
صدر عن هيئة نفسانية من غير فكر ولا روية سمى خلقاً، وكان صاحبه ظلوماً.
وهذه سبيل غيره من الأفعال المنسوبة إلى الخلق؛ لأنها صادرة عن هيئات
وملكات من غير روية.
فأما إذا ظهر الفعل بعد فكر وروية فليس عن خلق، مذموماً كان أو معلوماً،
وإذا لم يكن عن خلق فكيف يكون عن خلق.
وإنما يستمر الفاعل على فعل ما بروية منه فتحدث من تلك الروية الدائمة
هيئة تصدر عنها الأفعال من بعد بلا روية، فتسمى تلك الهيئة خلقاً.
فأما الشيء الصادر عن هذه الهيئة، فإنه إن كان عملاً باقي الهيئة والأثر،
سمى صناعة، واشتق من ذلك العمل اسم يدل على الملكة التي صدر عنها كالنجار،
والحداد، والصائغ، والكاتب؛ فإن هذه الأعمال إذا صدرت من أصحابها بلا
روية، سموا بهذه الأشياء، ووصفوا بهذه الصفات.
فأما إن تكلف إنسان استعمال آلة النجارة، والحدادة، والكتابة، والصياغة،
فأظهر فعلاً يسيراً بروية وفكر، فعلى سبيل حكاية وتكلف، فإن أحداً لا يسمى
هذا نجاراً، ولا كاتباً؛ ولذلك لم يسم من عمل بيتاً وبيتين شاعراً، ولا من
خاط بسلك أو سلكين خياطاً.
والصناعة كلها تجري هذا المجرى؛ فهذه الأعمال كما نراها، والأفعال أيضاً
التي لا تبقي آثارها - جارية هذا المجرى.
وعلى هذه السبيل جرت أمور الأخلاق والأفعال الصادرة عنها؛ لأن الأخلاق
هيئات للنفوس تصدر عنها أفعالها بلا روية ولا فكر.
فأما الوزير الذي سمعته يقول: أنا أتلذذ بالظلم، فإن الإختيارات المذمومة
كلها إذا صار منها هيئات وملكات صارت شروراً، وسمي أصحابها: أشراراً.
وليس يختص الظلم في استحقاق اسم الشر، وخروجه عن الوسائط التي هي فضائل
النفس - بشيء دون أمثاله ونظائره.
وفقد هذه الوسائط هو شرور ورذائل تلحق النفوس، كالشره والبخل والجبن، سوى
أن الظلم اختص بالمعاملة، وترك به طلب الاعتذار والمساواة.
وهذه النسبة العادلة، والمساواة في المعاملة - قد بينها
أرسططاليس في كتاب الأخلاق، وأن المعاملة هي نسبة بين البائع والمشتري،
والمبيع والمشتري، وأن نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع على
التكافؤ، وفي النسبة والتبديل فيها، وعلى ما هو مشروح مبين في غيره من
الكتب.
فأما قولهم: لا يزال الناس بخبر ما تفاوتوا، فإذا تساووا هلكوا، فإنهم لم
يذهبوا فيه إلى التفاوت في العدل الذي يساوي بينهم في التعايش، وإنما
ذهبوا فيه إلى الأمور التي يتم بها التمدن والاجتماع.
والتفاوت بالآحاد ههنا هو النظام للكل.
وقيل: إن الإنسان مدني بالطبع، فإذا تساوى الناس في الاستغناء هلكت
المدنية، وبطل الاجتماع.
وقد تبين أن اختلاف الناس في الأعمال، وانفراد كل واحد منهم بعمل هو الذي
يحدث نظام الكل، ويتم المدنية، ومثال ذلك الكتابة التي كليتها تتم باختلاف
الحروف في هيئاتها وأشكالها وأوضاع بعضها عند بعض، فإن هذا الاختلاف هو
الذي يقوم ذات الكتابة التي هي كلية، ولو استوت الحروف لبطلت الكتابة.
مسألة زجرية ولغوية
لم صار الرجل إذا لبس كل شيء جديد قيل له: خذ معك بعض ما لا يشاكل ما عليك ليكون وقاية لك؟ ألم تكن المشاكلة مطلوبة في كل موضع؟ وعلى ذكر المشاكلة، وما المشاكلة، والموافقة، والمضارعة والمماثلة، والمعادلة، والمناسبة؟ وإذا وضح الكلام في هذه الألفاظ وضح الحق أيضاً في المخالفة، والمباينة، والمنافرة، والمنابذة.الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذا فعل عامي يذهب إلى صرف العين.
وعند القوم أن الشيء إذا كمل من جهاته أسرعت العين إليه بالإصابة، فإذا كان منه شيء منتقص، أو ظاهر فيه عيب، شغلت العين به عن الإصابة.
وكان ينبغي ألا تختلط هذه المسائل هذا الاختلاط، فإني أرى المسألة الشريفة الصعبة إلى جانب الأخرى التي لا نسبة بينهما قلة وسهولة.
وليس للمجيب أن يقترح السؤال، وينظم الشكوك؛ ولأجل هذا اضطرت إلى الكلام في جميعها على حسب مراتبها.
ولم أقل ذلك إبطالاً للعين وأفعالها، ولا زراية على الأصول التي بنت العامة عليها، ولكن المسألة توجهت عن فعل عامي، وإن كان له أصل بعيد، ورجع إلى أول، وأسند إلى حقيقة.
فأما المسألة عن المشاكلة والموافقة، فإن الشكل المثل، وهي مفاعلة منه، ولا فرق بينها وبين المماثلة على ما ذكره اللغويون.
وأنا أظن المثل أعم من الشكل؛ لأن شكل مثل، وليس كل مثل شكلاً.
فأما الموافقة فمن الوفق في المسألة التالية لهذه المسألة، ونحن نشرحه هناك مع ذكر البخت والجد.
فأما المضارعة فهي المشابهة، وهي مفاعلة من الضرع، ومنه أصله واشتقاقه.
فأما المعادلة والمناسبة فقد مر ذكرها مستقصى في مسألة العدل.
والعدل لما كان يماثل عدله بالموازنة صار قريب المعنى منه، والمعادلة هي مفاعلة منه.
وقلت في آخر المسألة: إنه إذا وضحت لك هذه الألفاظ وضح بها ما بعدها.
فلذلك أمسكت عنها.
مسألة خلقية لم اشتدت عداوة ذوي الأرحام والقربى
حتى لم يكن لها دواء؛ لشدة الحسد، وفرط الضغائن، وحتى زالت بها نعم، وبادت نفوس، وانتهى إلى الجلاء والهلاك؟.وهل كان الجوار وما يتعوذ بالله منه في شكل هذه العداوة أم لا؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد تقدم في مسألة حد الحسد، وفي المعاني القريبة التي يغلط الناس فيها، وفي ذكر أسمائها، ما فيه غنى عن إعادته في جواب هذه المسألة؛ لأنا ذكرنا هناك أن الاثنين أو الجماعة من الناس إذا اشتركوا في أمر، وجمعهم سبب فتساووا فيه مع تساويهم في الإنسانية ثم تفرد من بينهم واحد بفضيلة - حسده نظيره، أو غبطه.
وذوو الأرحام هم جماعة يشتركون في نسب واحد، ولا يرى أحدهم للآخر فضلاً، فإن انفرد واحد منهم بأمر نافسه الآخر.
وأيضاً فإن موضوع الشركة في النسب هو المؤازرة والمعاونة والتساوي في الأحوال.
وهذه حال منتظرة يتوقعها كل واحد من الآخر، فإذا أخلف الظن كان أشد احتمالاً، وأصعب علاجاً، وصار بمنزلة الدين المجحود، والحق المغموط، فإذا اقتضى ثقل، وإذا ثقل تنوكر، وإذا تنوكر ثارت قوة الغضب بالجميع والغضب يزرع الحقد، ويبعث على الشرور.
وينضاف إلى هذا شدة العناية والتفقد للأحوال، وهذا لا يكون مع
البعداء، ولا يمكن فيهم، فتكثر وجوه المطالبات بالحقوق وادعاؤها وإن لم
تكن، وتثور أسباب الغضب، والغضب يرى أكثر مما تريه الحال نفسها، ويطلب كل
واحد من صاحبه، وينتظر مثل ما يطلبه صاحبه وينتظره، وينتهي من العدد وكثرة
الوجوه إلى حيث يتعذر دواؤه، ويقع الإياس منه.
والجوار أيضاً سبب قوى؛ لأنه شركة ما تبعث على تفقد الأحوال وتلقح الحسد،
وجميع الأحوال التي ذكرناها في ذوي الأرحام، إلا أن هناك عطفاً مرجواً،
وإبقاء معلوماً لا يوجد مثلهما في الجوار، فالشر إذا ثار منه صرف، والحسد
فيه محض، لا مزاج للخير فيه، ولا داعي إلى البقيا معه.
مسألة طبيعية لم غضب الإنسان من شر ينسب إليه وهو فيه
؟وما سبب غضبه من شر ينسب إليه وليس هو فيه؟ والصدق في الأول من باب المحبوب المحمود، والكذب في الثاني من باب المذموم المكروه.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: سبب ذلك محبة النفس، وقد تقدم شرحه.
والإنسان إذا ذكر بشر هو فيه كره أن يفطن له، وإن فطن له أن يجبه أو يغتاب به؛ لأنه يعرف قبح الشر، ويحب لنفسه التي هي حبيبته أن تكون بريئة من كل عيب، بعيدة من كل ذنب وذم، فإذا رميت بشر لحقه غم أولاً، ثم محبة الانتقام ممن غمه.
والغضب حقيقته حركة النفس للانتقام، وهذه الحركة تثير دم القلب حتى يغلي؛ ولذلك يحد الغضب بأنه غليان دم القلب شهوة الانتقام.
فأما غضب الإنسان من شر ينسب إليه وليس هو فيه فبالواجب؛ لأنه قصد بالظلم ليغم.
وفائدة الغضب، وسبب وجوده في الإنسان هو أن ينتصر به من الظالم، أو يمنعه ويضعه عن نفسه؛ فإذا علم الإنسان أن قاصداً يقصده بالظلم أحب الانتقام منه وتحركت نفسه لذلك، فحدث الغضب.
فقد استبان من الصدق والكذب جميعاً في هذه المسألة، سبب هيج الغضب، ومائيته أيضاً.
مسألة نفسانية ما علة حضور المذكور عند مقطع ذكره
وهو لا يتوقع فيه؟ هذا كثير معهود، وإن لم يكن من باب المعتاد المألوف، ولو كان من ذلك لسقط التعجب، وزال الإكبار، ووقع الإشتراك.ومن هذا الضرب رؤية الإنسان بالالتفات من لم يكن يظن أنه يراه.
وكذلك تشبيهك بعض من يلحقه طرفك بمعهود لك، حتى إذا حدقت نحوه لم يكن ذاك، ثم إنك لا تلبث حتى تصادف المشبه به.
وهل هذا كله بالاتفاق؟ وإن كان بالاتفاق فما الاتفاق؟ وهل الاتفاق هو الوفاق؟ وما الوفاق؟ حتى يكون البيان عنه بياناً عن الأول، أو مطلعاً عليه، أو مقرباً إليه.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن النفس علامة بالذات؛ دراكه للأمور بلا زمان؛ وذاك أنها فوق الطبيعة، والزمان إنما هو تابع للحركة الطبيعية، وكأنه إشارة إلى امتدادها؛ ولذلك اشتق اسم المدة منه؛ لأن المدة فعلة، والامتداد افتعال، وأصلهما واحد من المد.
ولما كانت النفس فوق الطبيعة، وكانت أفعالها فوق الحركة، أعني في غير زمان؛ فإذن ملاحظتها الأمور ليست بسبب الماضي ولا الحاضر، ولا المستقبل، بل الأمر عندها في السواء، فمتى لم تعقها عوائق الهيولى والهيوليات، وحجب الحس والمحسوسات - أدركت الأمور،وتجلت لها بلا زمان، وربما ظهر هذا الأمر منها في بعض المزاجات أكثر حتى يرتفع إلى حد التكهن والإنذار بالأمور المستقبلة.
وهذا الإنذار ربما كان في زمان بعيد، فكلما كان أبعد، والمدة أطول، كان أبدع عند الناس وأغرب، ثم لا يزال يقرب الزمان، ويقصر فيه، حتى يتلو وقت الإنذار بلا كبير فاصلة.
وهذه الحال تعرض لمن يذكر الإنسان فيحصر المذكور عند مقطع ذكره، ولم يكن سبباً لحضوره، بل كان الأمر بالضد؛ فإن قرب حضوره أشعر النفس حتى أنذرت به.
وكذلك الحال في الرؤية بالالتفات؛ فإن قرب الملتفت إليه هو الذي حرك النفس حتى استعملت آلة الالتفاف.
واستقصاء هذا غير لائق بشرطنا في ترك الإطالة، ولولا ذلك لذكرنا أموراً بديعة من هذا الجنس، وفي هذا القدر كفاية وبلاغ فيما سألت عنه.
فأما مسألتك عن الاتفاق، وهل هو الوفاق؟ وما الوفاق؟ فقد وعدنا بالكلام فيه في مسألة تجيء بعد هذه.
ولعمري إن الاتفاق هو الوفاق؛ لأنه افتعال منه، والأصل واحد، والاشتقاق دال عليه.
وسنحبر عنه إخباراً كافياً عند ذكر البخت والجد، إن شاء الله.
مسألة تشتمل على نيف وعشرين مسألة طبيعية ولغوية
وفيها الكلام في البخت والاتفاق
ما الخصائص الفارقة بين حقائق المعاني في ألفاظ دائرة بين أهل العقل والدين، وهي أسماء طابقت أغراضها لكنها خفية الأصول جلية المعاني وهي: ما القوة، والقدرة، والاستطاعة، والطاقة؛ فهي القوة بالمحمول عليها، والشجاعة، والنجدة، والبطولة، والمعونة، والتوفيق، واللطف، والمصلحة، والتمكن، والخذلان، والنصرة، والولاية، والملك، والملك، والرزق، والدولة، والجد، والحظ.ولم أذكر البخت؛ فإنه ليس من كلام العرب، ومعناه قد التبس ببعض هذه الأِشياء، وكذلك المبخوت.
فأما المجدود، والمحدود، والمحظوظ، والحظى، والجدى، فكل ذلك مراد به معنى، ومرمى به غاية، ولكن البيان عنها عزيز، والتحقيق فيها شديد.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: وجدت في هذه المسائل مع اختلافها ما يتقارب، وما يتباعد في المعاني، فألفت الشكل إلى شكله، ولم أراع تأليفها ونظمها.
أما القوة فاسم مشترك يقال على القوة التي هي في مقابلة الفعل.
وهذا اسم خاص يستعمله الحكماء حسب، ولا يعرفه الجمهور، ومعناه أنه الشيء الممكن أن يظهر فيصير موجوداً بالفعل، فيقال: الجرو مبصر بالقوة، والإنسان كاتب بالقوة، وإن لم يكن في الوقت كذلك.
ويقال على القوة التي يشار بها إلى معان موجودة للنفس كقوة الإبصار، والإدراك، والفكر، والتمييز، والغضب، وما أشبهها.
ويقال على المعنى الذي في الحديد وأشباهه من الصلابة والامتناع على التثنى والكسر.
ويقال أيضاً على البطش والجلد الذي يختص الحيوان، وأظنك إياها عنيت بالمسألة؛ لأنها ذكرت مع الطاقة والقدرة.
وقد أصبت حداً يعم أكثر هذه الأسماء، ويخص مسألتك، وهو أن القوة حال لذي القوة تظهر عند ما هي قوة عليه.
فأما شرح هذا الحد بحسب ما يختص الحيوان، فهو اعتدال في الأعصاب بين الرطوبة واليبوسة، وذلك أن العصب إذا أفرط في الرطوبة استرخى عند العمل، فسمى مستعمله ضعيفاً، وإذا أفرط في اليبوسة انبتر وانقطع، أو خشى عليه ذلك، وألم عند العمل؛ فكان مستعمله أيضاً ضعيفاً.
وليس يطلق اسم القوة إلا بالإضافة، وعلى حسب موضوع ذي القوة، فقد يقال: رجل قوى، وجمل ضعيف، كما يقال: نملة قوية، وفيل ضعيف.
فأما الطاقة فهي وفاء القوة بالمحمول عليها، وهي مستعملة في الحيوان، وفي قوته خاصة، وفي الأثقال الجسمانية.
وقد تستعمل أيضاً في الأثقال النفسانية تشبيهاً واستعارة، فيقال: فلان يطيق حمل مائة منا أى قوته وفاء بهذا الثقل إذا حمله، ويقال: فلان يطيق الكلام، ولا يطيق النظر، ولا الغم والسرور.
فإن استعمل في غير الحيوان فعلى المجاز البعيد.
فأما القدرة فهي تمكن من إظهار هذه القوة عند الإرادة ولذلك تختص بالحيوان، ولا تستعمل في غيره ألبته لما حددناه به.
وأما الاستطاعة فهي استفعال من الطاعة، أي استدعاؤها، هذا بحسب الاشتقاق، ودليل اللغة.
فأما على الحقيقة فهي كلمة مستعارة؛ وذلك أنك لا تستدعي طاعة شيء لك إلا وأنت تستحقها منه بالقدرة عليه.
وتلخيص هذا الكلام أنك إذا قلت: استطعت كذا، وأنا أستطيع الأمر، أي إذا استدعيت طاعته أجابني.
وهي توول إلى معنى القدرة وإن كانت أقدم منها بالذات، وكان بينهما فرق من هذا الوجه؛ لأن النفس هي التي تستدعي طاعة الشيء بالقدرة عليه، وتحكم بإجابته لها.
وهذه المعاني مضمنة لفظة الاستطاعة، واشتقاق الاسم دال عليه، فتأمله تجده واضحاً إن شاء الله.
فأما الشجاعة فهي استعمال قوة العصب بقدر ما ينبغي، وفي الوقت الذي ينبغي، وفيما ينبغي، وعلى الحال التي تنبغي.
وهي خلق يصدر عنه هذا الفعل على ما يحده العقل، وهي حال واسطة بين طرفين مذمومين: أحدهما زيادة بالإفراطن والأخرى زيادة بالتفريط.
فأما من جانب الزيادة فأن تستعمل بأكثر مما ينبغي في سائر شرائطها فتسمى تهوراً.
وأما من جانب النقصان فأن تستعمل بأقل مما ينبغي في سائر شرائطها، فتسمى جنباً.
والشجاعة لفظة مدح كالجود والعفة، وما جرى مجراهما.
وأول ما يظهر منها أثرها في الإنسان نفسه إذا قمعت شهواته، فاستعمل منها قدر ما يحده العقل بسائر شرائطها ثم يظهر أثرها في غيره إذا قصده آخر بضيم أو ظلم، فإنه يدفعه عن نفسه بالشروط المذكورة من غير إفراط ولا تفريط.
وأما النجدة، فهي في معنى الشجاعة، أعني أنها لفظة مدح، وتؤدي عن
معناها، إلا أنها بحسب اللغة مأخوذة من الارتفاع، والرجل النجد كأنه
المرتفع عن الضيم، الذي علا عن مرتبة من يستذل ويمتهن، كالنجد من الأرض
الذي هو ضد الغور.
وأما البطولة - وإن كانت في معنى الشجاعة - فإنها مختصة بما يظهر في
الغير، ولا تستعمل في قهر الإنسان شهوات نفسه، وهي تابعة للفروسة، كما
يقال فارس بطل.
وأخلق بالبطولة أن تكون عائدة إلى معنى البطلان؛ لأن صاحبها - أبداً -
متعرض لذلك من الفرسان، لا سيما والعرب لا تميز بين الشجاعة الممدوحة،
وبين الزيادة فيها المذمومة، بل عندها أن الإفراط هو الشجاعة.
فأما ما سميناه نحن شجاعة - فهو بالإضافة إلى ما سمته بها - جبن، كما
فعلوا ذلك في السخاء والجود، فإنهم استعملوا هذا المذهب بعينه.
وأقول: إن الشجاعة ربما أدت إلى بطلان الحياة، وكان الموت حينئذ خيراً
جيداً ممدوحاً لما وقع بحسب الشجاعة، أعني على ما حده العقل، وكما ينبغي،
وعلى سائر الشروط؛ لأنه لو قصر صاحبها، أعني الشجاعة، لكان مذموماً جباناً
كما بينا وأوضحنا، وكما تقدم من شرحنا معنى الموت الجيد، والحياة الرديئة،
فيما تقدم.
فأما المعونة، فهي إمداد القوة بقوة أخرى من جنسها خارجة عنها.
والخذلان ترك هذا الإمداد مع التمكن منه.
فإذا كانت المعونة من البشر، كانت نافعة مرة، وضارة مرة؛ لجهلهم بعواقب
الأمور، ولكن اسم المعونة اسم المدح؛ لأن المعمول عليه بين الناس هو النية
والقصد في الوقت، لا عواقب الأمور.
فأما إن كانت من الله - تعالى - فليست إلا نافعة غير ضارة؛ لعلمه
بالعواقب، ولأن الله - تعالى - لا يفعل إلا الخير والنافع، وهو متعال عن
الشر، منزه عنه، جل ذكره، وتقدس اسمه، وعلا علواً كبيراً عما يقول
الظالمون.
وإذا تبين ما العونة، وكيف تقع من البشر ومن البارى - تعالى - فقد تبين
ضدها الذي يسمى الخذلان، فلا معنى لإطالة الكلام فيه.
فأما اللطف والمصلحة فلفظتان مختصتان بأصحاب الكلام، وإن كانتا أيضاً
معروفتين عند الجمهور، ومعناهما عند القوم معروف.
وأنت - أبقاك الله - ريان شبعان من كلامهم ومعانيهم وأغراضهم، غير محتاج
أن نتكلف لك إيضاح شيء منها.
زادك الله، وامتع بالنعمة فيك.
وأما التمكين فهو تفعيل من الإمكان، والإمكان في الشيء هو جواز إظهار ما
في قوته إلى الفعل، وطبيعته بين الواجب والممتنع.
وذلك أنك إذا تصورت طبيعة الواجب كان طرفاً، وبإزائه في الطرف الآخر -
أعني ما هو في غاية البعد منه - طبيعة الممتنع، وبينهما طبيعة الممكن.
ولأجل هذا صار للممكن غرض كبير، ولم يكن للواجب، لا للممتنع غرض؛ لأن بين
الطرفين مسافة تحتمل الانقسام الكثير، فأما الطرف فلا مسافة له، والمسافة
التي بين هذين الطرفين - أعنى الواجب والممتنع - إذا لحظت وسطها على
الصحة، فهو أحق شيء وأولاه بطبيعة الممكن.
وكلما قربت هذه النقطة التي كانت وسطاً إلى أحد الطرفين كان ممكناً بشرط
وتقييد، فقيل: ممكن قريب من الواجب، وممكن بعيد منه.
وكذلك يقال في الممكن القريب من الممتنع، والبعيد منه.
فأما إذا كان في الوسط فهو ممكن على الإطلاق، وحينئذ ليس هو بالواجب أولى
منه بالممتنع، لا هو بأن يظهر من قوته إلى الفعل أولى من أن يبقى بحاله في
القوة.
فالتمكين هو مصدر مكن تمكيناً كما تقول: كرم تكريماً، وكلم تكليماً،
والإمكان مصدر أمكن إمكاناً كما تقول: أكرم إكراماً.
والممكن مفعل منه كما تقول مكرم.
وأما الاسم الذي منه اشتق هذا الفعل فلم يستعمل في اللغة، ولا جاء منه
ذلك؛ لأن الشيء لا فعل له إلا الفعل المتعدي بالهمزة، فإذا قلت في الشيء:
هو ممكن، فكأنك قلت: إن هذا الشيء الذي في القوة - ولم يستعمل له اسم، وهو
في التقدير، وتقديره الممكن - قد أعطاك ذاته، وجعل من نفسه بحيث تخرجه إلى
الفعل بالإرادة.
والإمكان مصدر أمكن الشيء من ذاته.
فأما التمكين فهو فعل شيء آخر بك، إذا جعلك من هذا الشيء بحيث تخرجه إلى
الفعل بالإرادة، وهو مصدر مكن، وهذا التشديد يجىء في مثل هذا الوضع من
اللغة إذا أريد به تكرير الفعل وتأكيده، كما تقول: ضرب وضرب، وشد وشدد.
وقد يجيىء التمكين بمعنى آخر، وهو أن يكون تفعيلاً مشتقاً من
المكان، كما تقول: مكنت الحجر في موضعه إذا وافيته حقه من مد المكان
ليلزمه، ولا يضطرب.
ومنه تمكن الفارس من السرج، وتمكن الإنسان من مجلسه.
وتمكن الإنسان من الأمير من هذا على التشبيه والاستعارة.
وبين هذا المعنى والمعنى الأول بون بعيد كما تراه.
وأما الرزق فهو وصول حاجات الحي إليه بما هو حي.
وههنا أشياء توصل إلى هذه الحاجات، وهي عوض منها، ونائبة عنها، أعني ما
يتعامل عليه، فجعلت كأنها هي، وسميت أيضاً أرزاقاً لما أدت إليها، والأصل
الأول، قال الله تعالى: " بسم الله الرحمن الرحيم " ولهم رزقهم فيها بكرة
وعشياً " صدق الله العظيم " .
ولما كانت أسباب الوصول إلى الحاجات كثيرة: فمنها قريب، ومنها بعيد، ومنها
طبيعي، ومنها غير طبيعي.
وغير طبيعي منها اتفاق ومنا غير اتفاق، وغلط الناس ضروباً من الغلط: منها
أنهم راموا أن يجعلوا الأسباب الكثيرة سبباً واحداً، ومنها أنهم راموا في
الأسباب البعيدة القرب، فلما خفى عنهم ذلك ولم يجدوه حيث طلبوه - لحقتهم
الحيرة، وبقدر جهلهم بالسبب عرض لهم التعجب من الأمر.
فأما الدولة فمن قولك دال الشيء بين القوم، وتداولوه بينهم إذا اعتوروه
بالمعاطاة، قال الله تعالى: " بسم الله الرحمن الرحيم " كي لا يكون دولة
بين الأغنياء منكم " صدق الله العظيم " ، أي ليتعاوره الكل ولا يخص قوماً
دون قوم.
وهي لفظة مختصة بالأمور الدنيوية المحبوبة لا سيما الغلبة.
وأسبابها أيضاً كثيرة: فمنها بعيد، ومنها قريب، ومنها طبيعي، ومنها غير
طبيعي، وغير الطبيعي منقسم إلى الإرادي والإتفاقي.
وكل واحد من هذه الأقسام أيضاً ينقسم وتبعد علله وتقرب وتختلط، ويتركب
ضروب التراكيب، فإذا فقد الجمهور وجود سببه عرض لهم فيه من الحيرة والتعجب
ما عرض في الرزق.
فأما التوفيق والاتفاق، والموافقة والوفاق، فقد مر ذكرنا كل واحد منها
منفرداً، وفي مسائل متفرقة، ووعدنا الكلام عليها في هذا الباب مع ذكر
البخت والجد، لأنها أشكال وقرائب.
وهذه الألفاظ الأربعة التي عددناها متقاربة المعاني، وهي مشتقة من الوفق،
وهي من ألفاظ الإضافة؛ لأنها لا تقع إلا بين شيئين، أو بين الأشياء.
ويقال هذا وفق هذا، أى لفقه وطبقة وملائمه، ويستعمل في كل متلائمين من
جسمين وخلقين وغيرهما.
وفي المثل: وافق شن طبقة، وافقه فاعتنقه، فقولك وافق فاعل من الوفق.
وهذا الوزن يجىء في كلام العرب لما كان بين اثنين، وكان كل واحد منهما
وافق الآخر، وهو موافق، كما قيل: ضارب صاحبه فهو مضارب.
والاتفاق افتعال من الوفق.
وهذا الوزن يجىء فيما لم يكن فاعله خارجاً منه.
كما يقال: اقترب واعتلق واضطرب، والأصل في اتفق اوتفق.
وكل هذا مشتق من الوفق.
وهذا الوزن لا يجىء فيما لم يكن فاعله إلا الذي ذكرناه.
فإذا اجتمع شيئان أو أشياء على ملاءمة بينهما بسبب إرادي مجهول، وكان
منهما موافقة لإرادة إنسان ما - كان اتفاقاً له، ولا بد أن يكون فيه قسط
من الإرادة، ونصيب من القصد والاختيار، فإن لم يكن للإرادة فيه نصيب،
وإنما وقع بسبب طبيعي مجهول، وكان فيه أمر نافع لإنسان - كان بختاً له.
ولما كانت الأمور بعضها يتم بأسباب طبيعية، وبعضها بأسباب إرادية، وبعضها
يتركب، فيكون تمامه بأسباب طبيعية وأسباب إرادية، وكل واحد منهما يتم منه
أمر واحد محبوب أو مكروه، وإن اختلفت أسبابه بحسب إنسان إنسان ونحو غرض
غرض - خولف بين أمسائها؛ ليدل بها على اختلاف أسبابها.
وما كان من الأمور له سبب طبيعي بعيد أو قريب إلا أنه مجهول، ثم عرض أن
يكون نافعاً لإنسان من غير إرادة، ولا قصد - سمي بختاً.
وما كان من الأمور له سبب إرادي بعيد أو قريب إلا أنه مجهول، ثم عرض له أن
يكون نافعاً لإنسان، موافقاً لغرض له وإرادة - سمي اتفاقاً.
ولا يشتق للإنسان اسم من هذين إلا بعد أن يتكرر له أمر، أعني أنه إنما
يسمى مبخوتاً إذا عرض له مرات كثيرة أن تحدث أفعال طبيعية لأسباب لها
مجهولة، فتتم بها أغراض مطلوبة محبوبة.
وأيضاً فإنما يسمى موفقاً إذا عرض له مرات كثيرة أن تقع أفعال إرادية
لأسباب لها مجهولة، فتتم بها أغراض جميلة محبوبة.
وأنا أكشف هذين المعنيين بمثالين ليضح أمرهما وينكشف.
على أني رأيتك تستعفي أن تفهم معنى البخت، لأنك لم تجده في كلام
العرب، كأنك خطرت على نفسك أن تفهم حقيقة إلا أن تكون في لفظ عربي، فإن
عدمت لغة العرب رغبت عن العلوم، لكنا - أيدك الله - لا نترك البحث عن
المعاني في أي لغة كانت، وبأي عبارة حصلت، فأقول: أما مثال البخت فأن يسقط
حجر من مكان عال، فيصيب رجلاً في عضو له تنفجر منه عروق، ويخرج منه الدم،
فإن كان الرجل محتاجاً قبل ذلك إلى إخراج الدم صار سقوط الحجر الذي فجر
العرق، وأخرج الدم سبباً لصحته، ومنع المرض عنه، فهذا بخت جيد.
فإن كان عرض للرجل أشياء كثيرة تشبه هذا فهو مبخوت.
وإن كان خروج الدم غير نافع للرجل، ولا كان به حاجة قبل ذلك إلى إخراجه،
بل تعجل بسقوط الحجر الألم، وبخروج الدم سقوط القوة، والوقوع في مرض كان
غير مستعد له، فهو بخت ردىء.
وأما المثال في الاتفاق فإن يخرج إنسان من منزله بإرادة وقصد إلا أنهما
كانا منه نحو التماس الحاجة، فلقي في طريقه ذلك صديقاً كان يهوى لقاءه، أو
غريماً كان يطلبه فلا يجده، فهذا اتفاق جيد، فإن عرض للرجل مثال لهذا كثير
فهو موفق.
وإن كان لقاؤه أيضاً وافق عدوا كان يهرب منه، أو غريماً كان متوارياً عنه،
فهو اتفاق ردىء، والرجل إذا دام عليه مثل هذا غير موفق.
ولما كانت أسباب الحركات الإرادية إنما تكون من خواطر وعوارض للنفس ليست
بإرادة، إذ لو كانت عن إرادة لوجب من ذلك وجود إرادات لا نهاية لها، وهذا
محال - كانت هذه الخواطر والعوارض التي هي آثار وأفعال منسوبة إلى فاعل،
وقد قلنا إن فاعلها غير الإنسان، فهي إذن فعل غيره لا محالة، فإن كانت
مؤدية إلى خيرات ومنافع كانت منسوبة إلى الله - تعالى - وهو التوفيق،
تفعيل من الوفق، وهذا التوفيق ربما فعله الله - تعالى - بالعبد من غير
مسألة، وربما كان بعد مسألة وتضرع، إلا أن الناس كافة يرغبون إلى الله -
تعالى - فيها، ويسألونه إياها دائماً في كل زمان، فإذا سنحت هذه العوارض
والخواطر للنفس فزعت إلى حركات يتم بها وبغيرها أمر واحد مختار لإنسان ما
نحو غرض جيد له - كان توفيقاً وكان الرجل موفقاً.
فأما الجد فكأنه اسم شامل لهذين المعنيين جميعاً؛ لأن الإنسان إن وفق وبخت
فهو مجدود، وإن انفرد أيضاً بأحدهما فهو مجدود أيضاً.
وأما الحظ فهو القسم والنصيب.
ولما كان لكل إنسان نصيب من السعادة، وقسط من الخير مقسوم له من الفلك
بحسب مولده - كان ما يصيبه من ذلك منسوباً إلى الحظ.
فأما المحدود فهو الممنوع، واشتقاقه من الحد وهو المنع، ويقال للبواب حداد
من هذا، وكأن المحدود ممنوع مما يصيب غيره من الخير.
والحظى والجدى منسوبان إلى الجد والحظ، كما يقال تميمى وبكرى.
فأما النصر فهو المعونة إلا أنه فيما أدى إلى الغلبة والقهر، وقد قلنا ما
المعونة فيما سلف.
وأما الولاية فاسم مشترك، وتصرفه بحسب تصرف اسم المولي، أعني أنه يكون من
فوق، ويكون من أسفل، إلا أن الحقيقة فيهما أنهما حال توجب اختصاصاً
وتحققاً يدعو الأعلى إلى الحنو والشفقة، والأسفل إلى النصيحة والطاعة.
وإذا أخذ هذا الاسم بحسب الشريعة وأنه لفظ شرعي حد بقدر ذلك المعنى المشار
إليه، وإن كان الأصل ما ذكرناه.
فأما ملك الشيء فهو التفرد بنفاذ الحكم فيه.
وهذا قد يكون بالطبيعة، والشريعة، وبالاصطلاح: أما بالطبيعة فملك الإنسان
لأعضائه وآلاته الطبيعية، وحركاته التي يصرفها على إرادته.
وأما بالشريعة فمثل ملك الرق بالسبي لمن خالف أصول الشرع.
وأما بالاصطلاح فمثل المفاوضات التي تقع بين المتعاملين.
فأما الملك إلا أنه أكثر عموماً، وأظهر استيلاء، وهو مع قهر.
ونفوذ الأمر فيه على طريق عموم المصلحة بالشفقة؛ فإذا كان بحسب الشرع،
والقيام بقوانينه، وإنفاذ أحكامه، وحمل الناس عليه طوعاً وكرهاً، ورغبة
ورهبة، ونظراً لهم كافة بلا هوى ولا عصبية - فهو الملك الحقيقي الذي يستحق
هذا الاسم، ويستوجبه بحسب معناه.
وإن لم يكن بحسب الشرع وشروطه التي ذكرناها فهو غالبة، والرجل متغلب، ولا
يجب أن يسمى ملكاً، ولا صناعته ملكية، ولا نفوذ أمره بحسب الملك.
وقد استبان من هذا الكلام حقيقة الملك، والفرق بينه وبين المتغلب، وإن كان
شرح ذلك يضيق عن هذا المكان لكن الإشارة إليه كفاية بالغه.
؟؟؟
مسألة ما معنى قول الناس هذا من الله
وهذا بالله، وهذا إلى الله، وهذا على الله، وهذا من تدبير الله،
وهذا تدبير الله، وهذا بإرادة الله، وهذا بعلم الله؟ وحكاية طويلة في إثر
هذه المسألة عن شيخ هذه المسألة عن شيخ فاضل مقرظ، وجوابات له.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما الناس ومقصدهم بهذه الحروف
من المعاني، فلا يمكن أن يعتذر له؛ لكثرة وجوه مقاصدهم، واختلاف آرائهم
ومذاهبهم.
وليس من العدل تكليفنا ذلك، ولو ذهبنا نعدد آراء الناس لطال، فكيف
الاعتذار لهم، وتأويل أقوالهم.
وأنا أضمن بالجملة أن أعرفك وجه الصواب عندي في هذه المسائل، وما أذهب
إليه، وأجتهد لك في إيضاحه على غاية الاختصار والإيماء، كما شرطته في
الرسالة التي صدرت بها، فأقول: إن جميع ما يطلق على الله - تعالى ذكره -
من هذه المعاني، وما ينسب إليه من الأفعال والأسماء والصفات، إنما هو على
المجاز والتسمح، وليس يطابق شيء من حقائق ما تتعارفه بيننا بهذه الألفاظ -
شيئاً مما هناك.
وأول ذلك أن لفظة من في هذه المسائل تستعمل في اللغة وبحسب ما قاله
النحويون لابتداء الغاية، ولفظة إلى لانتهاء الغاية، والباء للاستعانة،
وكذلك سائر الحروف لها معان مبينة عندهم.
ولست أطلق شيئاً من هذه الحقائق في الله - عز وجل - إلا مجازاً، فإني لا
أقول إن لفعله ابتداء ولا نهاية، ولا له استعانة بشيء، فنطلق عليه الباء،
أعني أن يقال هذا تدبير الله، ولا تدبير هناك، ولا حاجة به إلى هذا الفعل
ولا غيره، وكذلك أقول في سائر الأفعال المنسوبة إليه، وكذلك أقول في
الأسماء والصفات التي أطلقت، ورخص فيها صاحب الشريعة، وإنما أتبع فيها
الأثر، وامتثل باستعمالها الأمر، وإلا فمن ذا الذي يطلق حقيقة الرحمن
الرحيم وغيرهما من الأوصاف على الباري المتعالي عن الانفعالات، وإنما
الرحمة انفعالاً للنفس تصدر بحسبها أفعال محمودة بيننا، وليس هناك شيء من
هذه المعاني والحقائق، ولكن لما كان الإنسان قدير الجهد والوسع، وليس عليه
ما لا يفي به ولا يطيقه - أطلق أكرم الأسماء التي هي ممدوحة شريفة بيننا
على الله - تعالى - كمثل السميع العليم، والجبار العزيز وأشباهها.
وأنا أعتقد أن الشرع خاصة أطلق لنا هذه الأسماء والصفات، ولو خلينا ورأينا
لما أقدمنا على شيء منها أصلاً برخصة ولا سبب.
فإذا سمعنا بشيء من هذه الأسماء والأفعال والحروف منسوبة إلى الله تعالى -
نظرنا فيه: فإن كان مطلقاً في الشريعة أطلقناه، ثم تأملنا مراد قائله، فإن
كان خيراً وحكمة وعدلاً تركناه ورأيه، وإن لم يكن كذلك، ولائقاً بإضافة
إليه أبطلناه، وزيفناه، وكذبنا قائله، ونزهنا بارئنا الواحد المنزه
المتعالي عن هذه الأوصاف الباطلة.
ثم إني وجدتك - أيدك الله - تحكي في هذه المسألة جوابات عن شيخ فاضل تثني
عليه، وتسكن إلى قوله، وتقنع بأجوبته، فرأيت أن أقنع أبا أيضاً لك بها،
وذلك أنك ذكرت في آخر المسألة ما هذه حكايته: طال هذا الفصل عن هذا الشيخ
في معان متفرقة، تجمع فوائد غريبة، بألفاظ مختارة، وتأليفات مستحسنة، ولو
أمكن أن يتلو كل ما تقدم مثل هذا لكان في ذلك للعين قرة، للروح راحة، ولكن
الوقت مانع من المفروض الموظف فضلاً عن غيره، وأنا إلى إتمام الرسالة أحوج
مني إلى غيره.
مسألة ما الإلف الذي يجده الإنسان لمكان
يكثر القعود فيه، ولشخص يتقدم الأنس به؟ وهذا تراه في الرجل يألف حماماً، بل بيتاً من الحمام، ومسجداً، بل سارية في المسجد.ولقد سمعت بعض الصوفية يقول: حالفتني حمى الربع أربعين سنة، ثم أنها فارقتني فاستوحشتها.
ولم أعرف لاستيحاشي معنى إلا الإلف الذي عجنت الطينة به وطويت الفطرة عليه، وضبغت الروح به.
الجواب: الإلف هو تكرر الصورة الواحدة على النفس، أو على الطبيعة مراراً كثيرة.
فأما النفس فإنما تتكرر عليها صور الإشياء إما من الحس، وإما العقل.
فأما ما يأتيها من الحس فإنها تخزنه في شيبه بالخزانة لها، أعنى موضع الذكر، وتكون الصورة كالغريبة حينئذ، فإذا تكرر مرات شيء واحد، وصورة واحدة زالت الغربة، وحدث الأنس، وصارت الصورة، والقابل لها كالشيء الواحد، فإذا أعادت النفس النظر في الخزانة التي ضربناها مثلاً - وجدت الصورة الثانية فعرفتها بعد أنس، وهو الإلف.
وهذا الإلف يحدث عن كل محسوس بالنظر وغيره من الآلات.
فأما ما تأخذه من العقل فإنها تركب منه قياسات، وتنتج منها صوراً
تكون أيضاً غريبة، ثم بعد التكرر تنطبع فيقع لها الأنس إلا أنه في هذا
الموضع لا يسمى إلفا ولكن علماً وملكة؛ ولهذا يحتاج في العلوم إلى كثرة
الدرس؛ لأنه في أول الأمر يحصل منه الشيء يسمى حالاً، وهو كالرسم، ثم بعد
ذلك بالتكرر يصير قنية وملكة، ويحدث الاتحاد الذي ذكرناه.
فأما الطبيعة فلأنها أبداً مقتفية أثر النفس، ومتشبهة بها، إذ كانت كالظل
للنفس الحادث منها، فهي تجرى مجراها في الأشياء الطبيعية؛ ولذلك إذا عود
الإنسان طبعه شيئاً حدثت منه صورة كالطبيعة؛ ولهذا قيل: العادة طبع ثان.
وإذا تصحفت الأمور التي تعتاد فتصير طبيعة وجدتها كثيرة واضحة أبين وأظهر
من الإلف الذي في النفس، كمن يعود نفسه الفصد، والبول، والبراز، وغيرها في
أوقات بعينها، وكذلك الهضم في الأكل والشرب، وسائر ما تنسب أفعالها إلى
الطبيعة.
مسألة طبية لم صار الصرع من بين الأمراض صعب العلاج
؟وبسبب ذلك نرى الطبيب كاليائس من برئه، ويقال: إنه فيمن طغن في السن وأخذ بدنه في الخلوقة أصعب، وفي الصبي اللين العود، الرطب الطين، السريع الحيلولة أقرب مراراً، وأسهل برءاً.
الجواب: قال أبو علي مسكوبه - رحمه الله: الصرع هو تشنج يحدث في الأعصاب، ومبدأ العصب الدماغ؛ لأنه من هناك ينبت في جميع البدن، وسبب هذا التشنج بخار غليظ يكون من بلغم لزج، وكيموس غليظ يسد منافذ الروح التي في بطون الدماغ؛ ولأن البخار - وإن كان غليظاً - فهو سريع التحلل، تكون الإفاقة سريعة بحسب تحلله.
وهذا الانسداد ربما كان من الدماغ نفسه، وربما كان باشتراك المعدة من بخار غليظ يرتفع إليه منها، وهو الأكثر، وربما كان باشتراك عضو آخر.
والعليل يحس قبيل وقت النوبة إذا كان من عضو غير المعدة كأن شيئاً ينشأ من هناك، وينجذب إلى فوق، فيربط الطبيب ذلك الموضع، ويلف عليه عصائب قوية، ليمنع البخار من الصعود إلى الدماغ.
ولما كان الصبي ضعيف الدماغ رطبه كان سريعاً إلى قبول البخارات، وحرارته في النشوء معمورة بكثرة الرطوبات، وليس البخار بشيء أكثر رطوبة كثيرة تضعف الحرارة عن تحليلها وإحالتها؛ فلذلك كثرت البخارات في رأسه، فحدثت منه السدد التي ذكرناها.
والطبيب الماهر لا يعالج الصبي بشيء من أدوية الصرع، بل يتركه، ويداوي الموضع بإصلاح الغذاء؛ فإن الطبيعة إذا قويت، وجف فضول الرطوبات عن جميع البدن، وذكت الحرارة - زال الصرع لنفسه لزوال السبب، أعني البخار الكثير، ولصلابة جوهر الدماغ، وقلة قبوله الآفات التي كان سببها رطوبته وضعفه، وإنما غاية الطبيب إصلاح اللبن للمرضعة بالغذاء الذي يعدله حسب.
فأما الطاعن في السن، فإن أمره بالضد؛ لأن ضعف آلاته كلها يكون من قبل الانحطاط، وضعف القوى والأعضاء، وليس ينتظر بها أن تتزيد في القوة بل هي في كل يوم إلى النقصان والضعف، فإذا قبل دماغه بخاراً غليظاً من نفسه أو من عضو آخر صار مغيضاً له، وازداد في كل نوبة قبولاً.
والحرارة التي هي سبب تخلخل البخارات أيضاً تضعف عن التحليل؛ فلذلك يقع اليأس منه.
ومن شأن المادة التي تنصرف إلى موضع البدن، إذا عاودته مراراً، أن تتسع لها المجارى، وتلزمها الطبيعة بالعادة التي ذكرناها في المسألة المتقدمة.
فالآلة تزداد ضعفاً، والمادة تزداد انصباباً، والبخار يزداد كثرة للرطوبة الغريبة التي تحدث في أبدان المستعدين لها واستحالتها بلغماً في معدتهم، والحرارة تزداد ضعفاً على التحليل.
ولا يكاد يقبل البرء لأجل ذلك.
مسألة ما سبب محبة الناس لمن قل رزؤه
حتى إنهم ليهيئون الطعام الشهي له، بالغرم الثقيل، ويحملونه إليه في الجون على الرءوس، ويضعونه بين يديه.وكلما ازداد ذلك الزاهد تمنعاً ازداد هؤلاء لجاجة، فإن مات اتخذوا قبره مصلى، وقالوا: كان كثير الصوم، قليل الرزء.
وإذا عرض لهم من يأكل الكثير، ويتذرع في اللقم مقتوه ونبدوه، وكرهوا قربه واستسرفوا أدبه؟ ولعلة ما هجر الناس زيارة مقابر الملوك والخلفاء، ولهجوا بزيارة قبور أصحاب البت والخلقان، وأهل الضعف والمسكنة.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: ذلك لأن الإنسان بنفسه
النامية يناسب النبات، وبنفسه المتحركة بالإرادة يناسب البهائم، وبنفسه
الناطقة يناسب الملائكة، فهو إنما فضل وشرف بهذه الأخيرة.
والاغتذاء من خاصة النبات، وإن كان يعم الحيوان أيضاً لأجل ما فيه من
القوة النامية.
فأما النفس الناطقة فلا حاجة بها إلى الأكل والشرب.
ولما كانت الملائكة أشرف من الأنس؛ لاستعانها بذاتها عن الغذاء وبقاء
خروجها جوهرها - كان الإنسان المناسب لها بنفسه أكثر وأشرف من الإنسان
الذي يناسب النبات، والبهائم نسبة أكثر.
وكما أن الإنسان يستخف بالنبات والبهيمة، ويستخدمها، ويعظم الملائكة،
ويسبحها، فكذلك من الواجب في كل شيء كان مناسباً لتلك، أن يكون مهاناً
مستخفاً به، وكلما كان مناسباً لهذا أن يكون معظماً مشرفاً.
وهذا أبين من أن يبسط فيه قول، ويتكلف له جواب، ولكنا لم نحب الإخلال
بالمسألة رأساً؛ فلذلك علقنا فيه هذا القدر.
مسألة لم صار بعض الناس يولع بالتبذير
مع علمه بسوء عاقبته
؟وآخر يولع بالتقتير مع علمه بقبح القالة فيه؟ وما الفرق بين الرزق والملك؟ فقد قال لي شيخ من الفلاسفة - وقد سمعنى أشكو الحال - يا هذا، أنت قليل الملك كثير الرزق، وكم من كثير الملك قليل الرزق، أحمد الله عز وجل.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد تقدم لنا في هذه المسائل كلام في السبب الذي يختار الناس له فعل ما تقبح عاقبته مع علمهم بذلك، وضربنا فيه المثل بالمريض الذي يعلم أن تناول الغذاء الضار يبطل صحته؛ فإن الغذاء إنما احتيج إليه للصحة، فيختار للشهوة الحاضرة أخذ الغذاء الضار بسوء ملكته، وضبطه لنفسه، وانقياده للنفس البهيمية، وعصيانه للنفس الناطقة.
ولا وجه لإعادته.
وكذلك قد بينا مائية الرزق، والفرق بين الملك والرزق، وإذا قرأته مما تقدم جواباً لهذه المسألة.
مسألة خلقية لم يكن الناس لهجاً بطي ما يأتيه
وكتمان ما يفعله، ويكره أن يطلع على شيء من أمره؟ وآخر يظهر ما يكون منه، ويتشنع به، ويدل الناس على قليلة وكثيرة.
وما معنى قول النبي - عليه السلام - " استعينوا على أموركم بالكتمان؛ فإن كل ذي نعمة محسود " .
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد مضى أيضاً جواب هذه المسألة فيما تقدم، وقلنا: إن للنفس قوتين تشتاق بإحداهما إلى الأخذ، وبالأحرى إلى الأعطاء.
وكما يعرض للنفس في الأموال الشح والسماحة، كذلك يعرض لها في المعلومات، فمرة تسمح، ومرة تضن، وربما كان للإنسان شحيحاً بعلمه، سمحاً بماله، وبالضد.
وقد تقدم جميع ذلك مستقصى حيث تكلمنا على السر فيما مضى.
مسألة إرادية لم سمج مدح الإنسان لنفسه
وحسن مدح غيره له؟ وما الذي يحب الممدوح من المادح؟ وما سبب ذلك؟.الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: المدح تزكية للنفس، وشهادة لها بالفضائل، ولما كان الإنسان يحب نفسه رأى محاسنها، وخفى عليه مقابحها، بل رأى لها من الحسن ما ليس فيها؛ فقبح منه الشهادة بما لا يقبل منه، ولا يرى له.
فأما غيره فلأجل غربته منه، وخلوه من آفة العشق صارت شهادته مقبولة، ومدحه مسموعاً.
وربما كان هذا الغير يجري في محبة الممدوح مجرى الوالد، والأخ، والصديق الذي محله منه قريب من محل نفسه، فعرضت له تلك الآفة بعينها، أو قريب منها، فقبح ثناؤه ومدحه، ولم يقبل منه، وإن كان دون قبح الأول، أعني مادح نفسه؛ لأن أحداً لا يبلغ في محبته غيره درجة محبته نفسه.
فأما ما يجده الممدوح من المادح فهو حلاوة الإنصاف، وتأدية الحق، وسماع الكلام الطيب في المحبوب الموافق للإرادة.
مسألة إرادية وخلقية ولغوية ما سبب ذم الناس البخل
مع غلبة البخل عليهم؟ وما سبب مدحهم الجود مع قلة ذلك فيهم؟وهل الجود والبخل طبيعيان أو مكسوبان؟ وهل بين البخيل، واللئيم، والشحيح، والمنوع، والنذل، والوتح، والمسيك، والجعد، والكز - فروق؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما سبب ذم الناس البخل
فلأن البخل منه الحق من يستحقه على الشروط التي تقدم ذكرها، وهو في نفسه
أمر مستقبح عند العقل، وليس يمنع من استقباحه غلبته عليهم، وهو خلق مذموم،
ومرض للنفس مكروه، وكما لا يمنعهم ذم أمراض البدن وإن كانت موجودة لهم،
كذلك لا يمنع ذم أمراض النفس وإن كانت غالبة عليهم، على أن الإنسان في
أكثر الأمر يذم هذا العارض للنفس من البخل ولا يعترف أنه موجود فيه إلا
إذا كان منصفاً من نفسه، عارفاً بما لها وما عليها، فقد سمعت جماعة من
الأصدقاء يذمون أنفسهم بأمور ويشكون أنهم في جهد من مداواتها، وحرص على
إزالتها، وان العادة السيئة قد أفسدت عليهم كثيراً من أخلاقهم.
وأما سبب مدحهم الجود فلأن الجود في نفسه أمر حسن محبوب، وقد مر حده فيما
مضى، وهو في النفس كالصحة في البدن، فالناس يؤثرونه، ويمدحونه وجد لهم أم
لم يوجد.
وأما قولك: هل الجود والبخل طبيعيان أم مكسوبان؟ فإن الأخلاق بأجمعها ليست
طبيعية، ولو كانت كذلك لما عالجناها، ولا أمرنا بإصلاحها، ولا طمعنا في
نقلها وإزالتها إذا كانت قبيحة، ولكانت بمنزلة الحرارة والإضاءة في النار،
وبمنزلة الثقل والارجحنان في الأرض، فإن أحداً لا يروم معالجة هذه
الطبائع، ولا إزالتها ونقلها، ولكنا نقول: إنها - وإن لم تكن طبيعية -
فإنها بسوء العادة، أو بحسنها تصير قريبة من الطبيعة في صعوبة العلاج
وإزالة الصورة من النفس.
ولسنا نسميها خلقاً إلا بعد أن تصير هيئة للنفس يصدر أبداً عنها فعل واحد
بلا روية، فأما قبل ذلك فلا تسمى خلقاً، ولا يقال: فلا بخيل، ولا جواد إلا
إذا كان ذلك دأبه.
فأما الطفل والناشىء فقد يكون مستعداً بمزاج خاص له نحو قبول بعينه لكنه
بؤدب ويعود الأفعال الجميلة؛ لتصير صورة لنفسه، وهيئة لها يصدر عنها -
أبداً - ذلك الفعل المحمود، كما يكون مستعداً لقبول مرض بعينه فيعالج
بالأغذية والأدوية إلى أن ينقل من ذلك الاستعداد إلى ضده بتبديل المزاج
إلى أن يصح، ولا يقبل ذلك المرض.
وأما قولك: هل بين الألفاظ التي عددتها فروق، فلعمري أن بينها فروقاً: أما
البخيل واللئيم، فقد فرقنا بينهما فيما تقدم من أن اللؤم أعم من البخل؛
لأن كل لئيم بخيل، وليس كل بخيل لئيماً، واللؤم لا يختص بالمال والأعراض
حسب، بل يكون في النسب والهمة، والبخل خاص بالأخذ والإعطاء.
وأما المسيك، والمنوع فاشتقاقهما يدل على معناهما.
وأما المجعد والكز، فلفظتان مستعارتان مأخوذتان من الجمادات.
وأما النذل والوتح، فاسما مبالغه في الذم، وكل واحد أبلغ من الآخر،
والنذالة أبلغ من القلة والوتاحة، وفي مثل للعامة: فلان مقدد العرس وذكره
بعينه أرسططاليس.
ودلني على ان تلك اللغة وافقت هذه اللغة في هذا المثل، أو أخذه قوم عن قوم.
وهذا قد تجاوز البخل الذي هو منع الحق أهله على الشروط وانحط إلى غاية في
معاملة نفسه أكثر من غاية البخيل في معاملة غيره.
مسألة إرادية وخلقية وعلى ذم الناس البخل ومدحهم الجود
ما سبب اجتماعهم على استشناع الغدر، واستحسان الوفاء، مع غلبة الغدر وقلة الوفاء؟ وهل هما عرضان في أهل الجوهر، ام مصطلح عليهما في العادة؟ الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: سبب استحسان الناس الوفاء حسنه في العقل، وذلك أن الناس لما كانوا مدنيين بالطبع اضطروا إلى أمور يتعاقدون على لزومها؛ لتصير بالمعاونة أسباباً لتمام أغراض أخر.وقد تكون هذه الأمور في الدين السيرة وفي المودة والمعاملة، وفي الملك والغلبة، وبالجملة في كل ما يحتاج فيه إلى التمدن، وما يتم بالمعاونات فتقدم لها أسباب تعقد بينهم حالاً يراعونها أبداً في تمام ذلك الأمر، فإذا ثبت عليها قوم، ولزموها تمت أغراضهم، وإذا زالوا عنها، وخاس بعضهم ببعض فيها انتقضت عليهم الأغراض، وانتقضت عن بلوغ التمامات.
وبحسب الأمر المقصود بالتمام يكون حسن الوفاء وقبح الغدر، فإن كان الأمر شريفاً كريماً عام النفع استشنع الغدر فيه، واستحسن الوفاء، وبالضد.
مسألة في مبادىء العادات
ما مبدأ العادات المختلفة من هذه الأمم المتباعدة
فإن العادة مشتقة من عاد يعود، واعتاد يعتاد، فكيف فزع الناس إلى
أوائلها، وجروا عليها؟ وما هذا الباعث الذي رتب كل قوم في الزي، وفي
الحيلة، وفي العبارة، والحركة، على حدود لا يتعدونها، وأقطار لا يتخطونها؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: لعمري إن العادة من عاد يعود،
فأما السؤال عن مبادىء العادات، وكيف نزع الناس إلى أوائلها؟ وما كانت تلك
الأوائل؟ ومن شبق إليها ورتبها لكل قوم في الزى؟ فأمر لا أضمن لك الوفاء
فيه، ولو ضمنه ضامن لي لما رغبت فيه، ولا عددته علماً، ولا كان فيه طائل.
مسألة طبيعية لم لم يرجع الإنسان، بعدما شاخ وخرف
وكهلاً، ثم شاباً غريراً، ثم غلاماً صبياً، ثم طفلاً كما نشأ؟ وعلام يدل هذا النظم؟ وإلى أي شيء يشير هذا الحكم؟.الجواب: قال أو علي مسكويه - رحمه الله: ليست الشيخوخة والهرم نهاية نشوء الإنسان، ولا غاية الحركة الطبيعية، أعنى النامية، فتروم - أيدك الله - أن يعود الشيخ في مسالكها إلى المبدأ الذي تحرك منه، بل ينبغي أن تعلم أن غاية النشوء والحركة إنما هي عند منتهى الشباب ثم حينئذ يقف، وذلك زمان التكهل، ثم ينحط، وذلك زمان الشيخوخة؛ وذلك أن الحرارة الغريزية التي في الإجسام المركبة من الطبائع الأربع ما دامت في زيادة قوتها فهي تنشىء الجسم الذي هي فيه بأن تجتذب إليه الرطوبات الملائمة بدل ما يتحلل منها فتكون غذاء له، ثم تبقى بقية جذبها فضل القوة - فاضلة عن قدر الغذاء الذي عوض من المتحلل، فزادتها في مساحة الجسم، ومددت بها أقطاره، فإذا تناهت القوة وقفت فلم تزد في الأقطار شيئاً، بل غايتها حينئذ أن تحفظ على ذلك الجسم أقطاره ومقداره، بأن تغذية أعني أن تجتذب من الرطوبات مقدار ما يسري في الجسم عوضاً عما تحلل بلا زيادة تنصرف إلى التزييد والتمديد.
ثم إن الحرارة تضعف قليلاً، وتأخذ في النقصان بعد أن تقف وقفة في زمان التكهل، فيبتدىء البدن في النقص، ويصير الإنسان إلى الانحطاط عن تلك الحركة الأولى، فلا يزال الغذاء ينقص عن مقدار الحاجة، فلا يفي ما يعتاض من الرطوبة بما تحلل منها، فهو كذلك إلى أن يهرم، ويبلغ إلى الإنحلال الذي هو مقابل التركيب الذي بدأ منه، وهو الموت الصحيح الطبيعي.
وهذه سبيل كل حركة قهرية في أنها تبتدىء بتزيد، ثم تنتهي إلى غاية، ثم تقف وقفة، ثم تنحط.
ولما كان مزاج الإنسان وكل مركب من الطبائع المتضادة إنما كان بجامع جمعها، وقاهر قهرها حتى ألفها مع تضادها ونفور بعضها من بعض - صارت حركتها قهرية، ومن شأن الحركة القهرية ما ذكرت من أمرها إذا لم يتبعها القاهر أبداً، بقهر بعد قهر.
فوجب في حركة النشوء ما وجب في كل حركة من جنسها، ولم يعد الشيخ كهلاً، ثم شاباً، ثم طفلاً؛ لأن الحركة لم تقع على هذا النظام، ولا الشيخوخة هي غاية الحركة، بل هي غاية الضعف، ونظير الطفولة.
ووسط زمان الإنسان الذي بين الطفولة والشيخوخة هو غايته، ثم العود في الانحطاط والحركة يكون على سبيل ما بدأ.
مسألة إرادية ما الذي يجده الإنسان في تشبيه الشيء بالشيء
حتى يخطر ذلك المعنى على قلبه، ويلهج بذكره في قوافيه ونثره؟ ولم إذا لم يكن التشبيه واقعاً، والمعنى فيه بارعاً - أورث الصدود، ومنه الاستحسان؟.الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: الذي يجده الإنسان من ذلك هو السرور بصدق التخيل، وحسن انتزاع الصور من المواد حتى تأحدت الصورة بعد أن كثرتها المادة.
وذلك أن تشبيه الخوخة بالحمصة هو انتزاع الشكل الذي وجدفي مادتيهما وملاحظتهما شيئاً واحداً، وإن اختلفت به المواد في الكبر والصغر، والرطوبة واليبوسة، واللون، والمذاق، وغيرها من الأعراض.
والتفطن لذلك، وتجريد الصور من المواد، ورد بعضها إلى بعض من خاص فعل النفس، فالشرور به سرور نفساني، فلذلك يلهج به كما يلهج بما يظفر إذا كان طبيعياً، بل هذا أشرف وأفضل.
مسألة في الرؤيا ما السبب في صحة بعض الرؤيا
وفساد بعضها
؟ولم لم تصح الرؤى كلها، أو لم لم تفسد كلها؟ وعلام يدل ترجحها بين هذين الطرفين، فلعل في ذلك سراً يظهر بالامتحان.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد صح وثبت من المباحث
الفلسفية أن النفس أعلى من الزمان، وأن أفعالها غير متعلقة بشيء من
الزمان، ولا محتاجة إليه؛ إذ الزمان تابع للحركة، والحركة خاصة بالطبيعة،
وإذا كان ذلك كذلك، فالأشياء كلها حاضرة في النفس سواء الماضي والمستقبل
منها، فهي تراها بعين واحدة، والنوم إنما هو تعطيل النفس بعض آلاتها
إجماماً لها - أعني بالآلات الحواس - وهي إذا عطلت هذه الحواس بقيت لها
أفعال أخر ذاتية خاصة بها من الحركة التي تسمى رؤية وجولاناً نفسانياً.
وهذه الحركة التي لها في ذاتها تكون لها بحسب حالين: إما إلهياً وهو نظرها
في أفقها الأعلى، وإما طبيعياً وهو نظرها في أفقها الأدنى.
وكما أنها إذا كانت مستيقظة ترى بحاسة العين الشيء مرة رؤية جلية، ومرة
رؤية خفية بحسب القوة الباصرة من الحدة والكلال، وبحسب الشيء المنظور إليه
في اعتدال المسافة، وبحسب الأشياء الحائلة بينها وبينه من الرقة والكثافة.
وهذه أحوال لا يستوي فيها النظر، بل ربما نظر الناظر بحسب واحدة من هذه
العوارض إلى حيوان فظنه جماداً، وربما ظنه سبعاً وهو إنسان، وبما ظنه
زيداً وهو عمرو، فإذا زالت تلك الموانع، وارتفعت العوائق أبصرها بصراً
تاماً - كذلك حالها إذ كانت نائمة أي غير مستعملة آلة الحس إنما ترى من
الشيء ما يحصل من الرسم الأول - أعني الجنس العالي الشامل الأشياء التي هو
عام لها - ثم لا يزال يتخلص لها بصورة بعد صورة، حتى تراه صريحاً بيناً،
فإن اتفق أن ترى من الشيء رسمه احتيج فيما تراه إلى تأويل وعبارة، وإن
رأته مكشوفاً مصرحاً كانت الرؤيا غير محتاجة إلى التفسير، بل يكون الشيء
بعينه الذي رأته في النوم هو الذي ستراه في اليقظة.
وهذا هو القسم الذي لها بحسب نظرها السريع الشريف الذي من أفقها الأعلى،
وبه تكون الإنذارات والرؤيا الصادقة التي هي جزء من النبوة.
فأما القسم الآخر الذي لها بحسب نظرها الأدون من أفقها الأسفل، فإنها
تتصفح الأشياء المخزونة عندها من الصور الحسية التي إنما استقتها من
المبصرات والمسموعات بالحواس وهي منثورة لا نظام لها، ولا فيها إنذار
بشيء، وربما ركبت هذه الصور تركيباً عبثياً كما يفعله الساهي أو العابث من
أفعال لا يقصد بها غرضاً كالولع بالأطراف، وبما يليها من الأشياء ولا
فائدة له فيها.
وهذه الرؤى لا تتأول، وإنما هي الأضغاث التي سمعت بها.
مسألة ما الرؤيا فقد جل الخطب فيها
وهي جزء من أجزاء النبوة، وما الذي يرى وما يرى؟ وما الذي يرى ما يرى؟ النفس أم الطبيعة أم الإنسان؟ وأكره أن أرقى إلى البحث عن النفس، وتحقيق شأنها، وما قال الأولون والآخرون فيها.وإذا كان هذا معجزاً، وعن الطاقة بارزاً، فما ظنك بالبحث عن العقل، وأفقه أعلى، وعالمه أشرف، وآثاره ألأطف، وميزانه أشد اتصالاً، وبرهانه أبعد مجالاً، وشعاعه أقوى سلطاناً، وفوائده أكثر عياناً.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن النفس ترى عند غيبة المرئيات ما تراه من حضورها، وذلك بحصول صورها في الحاس المشترك.
وهذه حال يجدها الإنسان من نفسه ضرورة لا يمكنه أن يدفعني عنها، وإلا فمن أين لنا صورة بغداد وخراسان والبلاد التي شاهدناها مرة، ثم منازلنا بها وصور أصدقائنا فيها، وجميع ما نتذكره منذ الصبي لولا حصول هذه الصورة في الحاس المشترك؟ سيما وقد تبين بياناً لا ريب فيه أن البصر وسائر الحواس إنما هي انفعالات من المحسوسات، واستحالات إليها، وهذه الاستحالة لا تثبت بعد زوال المحسوس المخيل، فلولا هذا الحاس المشترك العام الذي تثبت فيه صور المحسوسات ولا تزول، لكنا إذا أبصرنا شيئاً أو سمعناه ثم زال عن بصرنا وسمعنا زالت عنا صورته ألبتة حتى لا يمكننا أن نعرف صورته إلا إذا وقعت أبصارنا وأسماعنا عليه ثانياً، ولكنا أيضاً مع أبصارنا له ثانياً وثالثاً لا نعلم أنه الأول، وكذلك المسموعات.
ولولا أننا نستثبت صورة المحسوسات أولاً أولاً في هذه القوة -
أعني الحاس العام المشترك - لكنا لا نستفيد بالقراءة، ورؤية الرقص،
والحركات كلها التي تنتهي مع آنات الزمان شيئاً ألبتة؛ لأن البصر مستحيل
بقراءة الحرف بعد الحرف، وبالحركة بعد الحركة، فلا تثبت الحالة الأولى من
استحالتها، ولو ثبت الأولى لما حصلت الثانية، لكن الأمر بالضد في وجودنا
هذه الصور بعد مفارقتها كأنها نصب عيوننا، تراها النفس.
وهذه الرؤية التي تسمى تذكراً في اليقظة هي بعينها تسمى في النوم رؤيا
ولكن هناك حال أخرى زائدة على حال اليقظة؛ لأن قوى النفس عند تعطيل الحواس
تتوفر على الرؤية فترى أيضاً الأشياء الآتية في الزمان المشتقبل: إما رؤية
جلية، وإما رؤية خفيفة كالرسم.
واشتقاق هذه الألفاظ يذلك - أيها الشيخ اللغوي أيدك الله - أن المعنى فيها
واحد؛ لأن الرؤية، والروية، والرؤيا - وإن اختلفت بالحركات - فهي متفقة
بالحروف، وكذلك إذا قلت: رأى فلان، وارتأى وروى، فهذه صورة الأسماء
المشتقة، وأنت تعرف أحكامها لدربتك بها.
وكذلك الحال في أبصر، واستبصر، وفي البصر، والبصيرة.
فأما لفظة النظر فإنها استعملت بعينها في الأمرين جميعاً من غير زيادة ولا
نقصان، فقيل لما كان بالحس: نظر، ولما كان بالعقل: نظر، من غير تغيير
لحركة ولا تبديل لحرف.
فقد تبين ما الرؤيا، وما الذي يرى، وما الذي يرى: أما الرؤيا ملاحظة النفس
صور الأشياء مجردة من موادها عند النوم.
وأما الذي يرى فالنفس بالآلة التي وصفناها.
وأما الذي يرى فالصورة المجردة.
وقد مر في المسألة المتقدمة كيف يكون بعض المنام صادقاً، وبعضه كاذباً،
وبعضه إنذاراً، وبعضه أحلاماً، وبعضه أضغاثاً، ولكن بغاية الإيجاز؛ لأنا
لو شرحنا هذه المواضع لاحتجنا إلى تصنيف عدة كتب نقرر فيها الأصول، ونلخص
بعدها الحروف، ولكن الشرط سبق بغير هذا، وسرعة فهمك أمتع الله بك - وقبولك
لما يشار به - يقتضي ما رأيناه، ووأيناه.
مسألة إرادية وخلقية ما السبب في تصافي شخصين
لا تشابه بينهما في الصورة، ولا تشاكل عندهما في الخلقة
ولا تجاوز بينهما في الدار، كواحد من فرغانة وآخر من تاهرت، وهذا طويل قويم، وهذا قصير دميم، وهذا شخت عجف وهذا علج جلف، وهذا أزب أشعر، وهذا أمعر أزعر وهذا أعيا باقل، وهذا أبلغ من سحبان وائل، وهذا أجود من السحاب إذا سح بودق بعد برق، وهذا أيخل من كلب على عرق، إذا ظفر بعرق وبينهما من الخلاف والاختلاف ما يعجب الناظر إليهما، والفاحص عن أمرهما.وعلى ذكر الخلاف والاختلاف، ما الخلاف والاختلاف؟ وما الإلف والائتلاف؟ نعم، ثم لا تراهما إلا متمازجين في الأخذ والإعطاء، والصدق والوفاء، والعقد والولاء، والنقص والنماء، بغير نحلة عامة، ولا مقالة ضامة، ولا حال جامعة، ولا طبيعة مضارعة.
ثم هذا التصافي ليس يختص ذكراً وذكراً دون ذكر وأنثى، ودون أنثى وأنثى.
وإذا تنفس الاعتبار أدى إلى طرق مختلفة: منها أن التصافي قد يمتد، وقد ينقطع، ففيما يمتد ما يبلغ آخر الدهر، وفيما ينقطع ما لا يثبت إلا شهراً، أو أقل من شهر.
ومن أعجب ما ينبع منه العداوة، والشحناء، والحسد، والبغضاء، حتى كأن ذلك التصافي كان عين التنافي، وحتى يفضي إلى عظائم الأمور، وإلى غرائب الشرور، وإلى ما يفتي التالد والطارف، ويأتي على البقية المرجوة.
وربما سرت العداوة في الأولاد كأنها بعض الإرث، وربما زادت على ما كانت بين الآباء.
وهذا باب عسر، وللتعجب فيه مجال وموقع، والعلل فيه مخبوءة.
وقلما تصيب في زمانك هذا ذهناً يولع بالبحث عن غامضه، ويلهج بالمسألة عن مشكله.
وليتهم إذ زهدوا في هذه الحكم لم يقذفوا الخائضين فيها، والمنقبين عنها بالتهم!!!.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: سبب الصداقات بين الناس ينقسم أولاً إلى قسمين عاليين، وهما أسباب الذاتي، والعرضي.
ثم ينقسم كل واحد منهما إلى أقسام، وبحسب أقسام المودات تنقسم أيضاً أسباب العداوات.
وإذا عرف أحد المتقابلين عرف مقابله الآخر، لأن أقسامه كأقسامه.
أما السبب الذاتي من أسباب التصافي فهو السبب الذي لا يستحيل، ويبقي ببقاء الشخصين، وهو نسبة بين الجوهرين، إما من المزاج الخاص العناصر، وإما من النفس والطبيعة.
فأما المزاج فقد يوجد بين الإنسانين، وبين الهيمتين؛ فإن تشاكل
الأمزجة يؤلف ويجذب أحد المتشاكلين بها إلى الآخر من غير قصد ولا روية ولا
اختيار، كما تجد ذلك في كثير من أنواع البهائم والطير والحشرات.
وكذلك تجد بين الأمزجة المتباعدة عداوات ومنافرات من غير قصد ولا روية ولا
اختيار، وإذا تصفحت ذلك وجدته أكثر من أن يحصى.
وإن ارتقيت من الأمزجة إلى البسائط من الأمور وجدت هذا مستمراً أيضاً فيها
- أعني المشاكلة والمحبة والمنافرة والعداوة - فإن بين الماء والنار من
المنافرة والمعاداة، وهرب كل واحد منهما من صاحبه ليبعد عنه، ثم ميل كل
واحد منهما إلى جنسه، وطلبه لشكله ليتصل به - أمر لا خفاء به على أحد.
فإن انضاف إلى ذلك مزاج مناسب بتأليف موافق ظهر السبب وقوى، كما يوجد حجر
المغناطيس والحديد، وبين حجري الخل، أعني محب الخل، وباغض الخل.
وفي الحيوان من هذا المعنى شيء كثير بين لا يحتاج إلى تعديده، وإطالة
الجواب بذكره.
وإذا كان اتفاق الجسمين يوجب المودة بالجوهر وبالمزاج الخاص، فكم بالحرى
أن يوجبها اتفاق النفسين إذا كان بينهما مناسبة ومشاكلة.
وأما الأسباب العرضية فهي كثيرة، وبعضها أقوى من بعض: فأحد أسباب المودة
العرضية العادة والإلف.
والثاني الأمر النافع أو المظنون به النفع.
والثالث اللذة، والرابع الأمل، والخامس الصناعات والأغراض، والسادس
المذاهب والآراء، والسابع العصبيات.
ثم طول مكث أحد هذه الأسباب وقصره علة طول المودات وقصرها.
ومثال النافع مودات الأتباع أو الخدم وأربابهم، وأصحاب الشركة والتجارات،
وطلاب الأرباح والمكاسب.
ومثال اللذيذ مودة الرجل والمرأة، على أن هناك أيضاً مودة النافع، ومودة
الآمل، فهو لذلك قوى وثيق، ومودة المتعاشقين المتعاشرين على المأكول
والمشروب والمركوب، وما أشبه ذلك.
وأما مثال الرجاء والأمل فكثير، ولعل مودة الوالدين للولد فيها شيء من هذا
الضرب؛ لأنه متى زال الأمل، وقوي اليأس انتفيا من الولد، وزالت المودة،
وحدث البغض.
فأما مودة الولد فالنفع لا غير، ثم يصير مع ذلك أيضاً إلفاً.
ولست أقول إن الأسباب كلها مودة الوالدين ما ذكرته؛ فإن هناك أسباباً أخر
طبيعية، ولكن فيها شيء كثير من المعنى.
ومثال الصناعات والأغراض كثير ظاهر لا يحتاج إلى ذكره مع ظهور.
ومثال النحل والعصبيات كذلك أيضاً في البيان والظهور.
وهذه الأقسام محصورة تحت قوى النفس البهيمة والغضبية والناطقة.
فما كان منها عن نسبة ومشاكله بين النفس النامية والبهيمة كان منه أسباب
المودة للذيذ أو النافع.
وما كان منها بسبب مشاكلة بين النفس الغضبية كان منه أسباب المودة للغلبة
كالاجتماع للصيد والحرب، وسائر العصبيات التي تكون فيها قوة الغضب.
وما كان منها عن نسبة ومشاكلة في النفس الناظقة كان منه المودة التي للدين
والآراء.
وهذه تتركب وتنفرد، فكلما تركبت، وكثرت الأسباب قويت المودة، وكلما تفردت
ضعفت المودة، ويكون زمان المكث بحسب ذلك أيضاً.
وأقوى الأٍسباب المفردة العرضية ما كان عن النفس الناطقة، ويتلوه ما كان
عن النفس الغضبية.
وأنت تستقرىء ذلك وتتبينه لئلا يطول الجواب فيخرج عن الشرط الأول من تحري
الإيجاز.
وجميعها يزول بزوال أسبابها، وليس منها شيء ثابت لا يزول إلا الجوهري
الذاتي إما نفساً وإما طبيعة.
مسألة ما العلم؟ وما حده وطبيعته؟
فقد رأيت أصحابه يتناهبون الكلام فيه، حتى قال قوم: هو معرفة الشيء على ما
هو به.
وقال آخرون: هو اعتقاد الشيء على ما هو به.
وقال قائلون: هو إثبات الشيء على ما هو به.
فقيل لصاحب القول الأول: لو كان حد العلم معرفة الشيء على ما هو به لكان
حد المعرفة على الشيء على ما هو به، والحاجة إلى تحديد المعرفة كالحاجة
إلى حد العلم.
وهذا جواب فيه سهو وإيهام.
وقيل لصاحب القول الثاني: إن كان حد العلم اعتقاد الشيء على ما هو به فبين
أن كون الشيء على ما هو به سبق الاعتقاد، ثم اعتقد، والاعتقاد سبق كون
الشيء على ما هو به؛ فإن ما هو به هو المبحوث عنه، ومن أجله وضع العيار،
ولزم الاعتبار.
فقال المجيب مواصلاً لكلامه الأول: هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون
النفس، وثلج الصدر.
فقيل له: إن الاعتقاد افتعال من العقد، يقال: عقد واعتقد،
والكلام عقد، والتاء عرض لغرض ليس من سوس الكلمة؛ فإذن هو فعل مضاف إلى
العاقد الذي له عقد، والمعتقد الذي له اعتقاد، والمسألة لم تقع عن فعل،
وإنما وقعت عن العلم الذي له قوام بنفسه، وانفصال من العالم، ألا ترى أن
له اتصالاً به، فهب أنك تحده باعتقاد الإنسان الشيء ما دام متصلاً به، فما
حقيقته من قبل ولما يتصل به؟ وهذا جواب المعتزلة، ولهم التشقيق والتمطيط،
والدعوى، والإعراب، والعصبية والتشيع.
وقيل لصاحب هذا الجواب: لو كان العلم اعتقاد الشيء على ما هو به لكان الله
معتقداً للشيء على ما هو به؛ لأنه عالم.
فقال: إن الله - تعالى ذكره - لا علم له؛ لأنه عالم بذاته، كما هو قادر
بذاته حي بذاته.
فقيل له: إنك لم تمانع في هذه الحاشية فلا تتوار عن السهم، إن كان حد
العلم اعتقاد الشيء على ما هو به فحد العلم أنه معتقد للشيء على ما هو به.
وسيؤنف النظر: هل له علم أم ليس له علم؟ فراغ هكذا وهكذا.
وقيل لصاحب القول الثالث: إثبات الشيء عبارة مقصورة على إضافة فعل إلى
الفاعل، والفعل هو الإثبات، والفاعل هو المثبت، وباب العلم، والجهل،
والفطنة، والعقل، والنهي، والدرك - ليس من الأفعال المحضة، وإن كانت
مضارعة لها كمضارعة طال، ومات، ونشأ، وشاخ، واستعر، وباخ.
وهذا البحث متوجه إلى صاحب القول الرابع، أعني في قوله: حد العلم إدراك
الشيء على ما هو به.
وينبغي أن تعلم أن الغرض في حد الشيء هو تحصيل ذاته معراة من كل شائبة،
خالصة من كل مقذية بلفظ مقصور عليها، وعبارة مصوغة لها، وما دامت عين
الشيء ثابتة في النفس، ماثلة بين يدي العقل فلا بد للمنطق من أن يلحق منها
الحقيقة، أو يدرك أخص الخاصة.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما الأجوبة المحكية،
والاعتراضات عليها، فأنا معرض عن جميعها؛ إذ كان هؤلاء القوم الذين حكي
عنهم ما حكى لا يعرفون صناعة التحديد، وهي صناعة تحتاج إلى علم واسع
بالمنطق، ودربة - مع ذلك - كثيرة.
وغاية ما عند هؤلاء القوم في التحديد إبدال اسم كان اسم، بل ربما كان اسم
الشيء أوضح من الحد الذي يضعونه له.
وهذه سبيلهم في جميع ما يتكلفونه إلا ما كان مأخوذاً من المتقدمين،
ومنقولاً عنهم نقلاً صحيحاً كحد الجسم والعرض وما أشبههما.
فأما ما تكلفوه من الحدود فهو بالهذيان أشبه.
وأقول إن الحد مأخوذ من جنس الشيء المحدود القريب منه، وفصوله، الذاتية
المقمومة له، المميزة إياه عن غيره.
فكل ما لم يوجد له جنس، ولا فصول مقومه فإنما يرسم.
والرسم يكون من الخواص اللازمة التي أشبه بالفصول الذاتية، فلذلك ما نحد
العلم بأنه إدراك صور الموجودات بما هي موجودات.
ولما كانت الصور على ضربين: منها في هيولى ومادة، ومنها مجردة خالية من
المواد - صار إدراك النفس أيضاً على ضربين: أحدهما بالحواس وهو إدراكها
لما كان في مادة.
والآخر بغير الحواس، بل العين الباطنة الروحانية التي تقدم الكلام فيها في
بعض المسائل المتقدمة.
فاسم العلم خاص بإدراك الصور التي في غير مادة.
واسم المعرفة خاص بإدراك الصور ذوات المواد.
ثم يستعمل هذا مكان هذا الاتساع في اللغة.
ووجدتك دق اعترضت على أجوبة من لم ترتض جوابه باعتراضات يجوز أن تظن أنها
لازمة لجوابنا هذا؛ فلذلك احتجت إلى الكلام عليها، فأقول: إن من شأن الحد
أن ينعكس على المحدود، وذاك أن الاسم والحد جميعاً دالان على شيء واحد، لا
فرق بينهما إلا في أن الاسم يدل دلالة مجملة، والحد يدل دلالة مفصلة، مثال
ذلك أن تقول في حد الجسم: إنه الطويل العريض العميق، أو تقول: هو ذو
الأبعاد الثلاثة، ثم ينعكس ذلك: إن الطويل العريض العميق هو الجسم، أو ذو
الأبعاد الثلاثة هو الجسم.
وكذلك تقول في سائر الحدود الصحيحة؛ ولهذا تقول في العلم: إنه إدراك صور
الموجودات، وتقول أيضاً: إدراك صور الموجودات هو العلم، فلا يكون بينهما
فرق إلا أن العلم يدل دلالة إجمال، وحده يدل دلالة تفصيل على ما قدمناه
ذكره وبيانه.
وإذا بان أن العلم إدراك وتصور فقد بان أنهما انفعال، لأن الصور إنما تكون
موجودة: إما مجردة عقلية، وإما مادية حسية، وإذا أدركتها النفس فإنما
تنقلها إلى ذاتها نقلاً لتنطبع تلك الصور فيها، وإذا انطبعت فيها تصورت
بها.
وهذا مستمر في المحسوس والمعقول.
وإذا بان هذا، فقد بان أنه من باب المضاف؛ لأن الإدراك أثر يقع بالمنفعل
من الفاعل، وكذلك التصور.
والأشياء التي من باب المضاف لا سبيل إلى وجودها منفردة، ولا إلى تحصيل
ذواتها معراة من كل شائبة كما طالبت خصمك به؛ لأنها لا عين لها ثابتة في
النفس مائلة بين يدي العقل إلا من حيث هي مضافة؛ فالمعلوم إذن يتقدم العلم
تقدماً ذاتياً، وكذلك المحسوس يتقدم الحاس بالذات.
والفرق بين التقدم الذاتي، والتقدم العرضي والزماني بين في غير هذا الموضع
وإن كانا معاً بالزمان، ثم تنتزع النفس صورها وتستثبتها في ذاتها.
فأما ما ألزمته في خاصتك في الله - تعالى عن صفات المخلوقين - فقد عرفت
مما تقدم من المسائل أنا لا نقول فيه - تقدس ذكره - إنه عالم بالحقيقة
التي نقولها في العالم منا، ولا نطلق شيئاً من صفاته بالمعاني التي نطلقها
في غيره بوجه من الوجوه، وإنما نتبع الشريعة، ونتمثل ما تأمر به، ونسميه
بأحب الأسماء، ونصفه بأعظم الصفات التي نتعارفها نحن معاشر البشر؛ لأنه لا
سبيل لنا إلى غير ما نعرفه فيما بيننا، ولا طريق لنا إلا ما يستحقه - عز
وجل - ذاته؛ لأنا لا نعلم بالحقيقة منه شيئاً إلا الإنية المحض، حسب.
ثم جميع ما يشار إليه بعقل أو حس فهو مخلوق له.
وإذا كان الأمر كذلك، ووجدنا الشريعة قد رخصت في أسام وصفات ممدوحة عظيمة
بين البشر - ائتمرنا للشرع فأطلقناها من غير أن نرجع بها إلى الحقائق
المعروفة من اللغة، والمعاني المحصلة بها.
وهذا موضع قد أومأت إليه فيما سلف، وأعلمتك وجه الصعوبة فيه.
والله الموفق والمعين، ولا قوة إلا به.
مسألة لم إذا أبصر الإنسان صورة حسنة
أو سمع نغمة رخيمة قال: والله ما رأيت هذا قط، ولا سمعت مثل هذا قط، ولا سمعت مثل هذا قط، وقد علم أنه سمع أطيب من ذاك، وأبصر أحسن من ذاك؟.الجواب: قال أبو علي مسكويه: رحمه الله: أما بحسب الفقه أو مقتضى اللغة فهو غير حانث ولا مخطىء؛ لأن شيئاً لا يماثل شيئاً بالإطلاق، ولا يقال في شيء: هذا مثل هذا إلا بتقييد، فيكون مثله في جوهره، أو كميته، أو كيفيته، أو غير ذلك من سائر المقولات، وقد يماثله في اثنتين منها وأكثر، فأما في جميعها فمحال.
فهذا وجه صحة قول الإنسان: والله ما رأيت مثله.
فأما من جهة أخرى - وهي جهة طبيعية - فإنك تعلم أن الحس سيال بسيلان محسوسه، فإذا استثبت صورة، ثم زالت عنه، وحضرت أخرى شغلته وثبتت بدل الأخرى، فلا يحصر الحس إلا ما قد أثر فيه دون ما قد زال، وإنما حصلت الأولى في الذكر، وفي قوة أخرى، وربما لم يجتمعا، أو لم يحضر الذكر، فيكون قول الإنسان على حسب الحاضر، وحضور الذكر أو غيبته.
مسألة ما سبب استحسان الصورة الحسنة
؟وما هذا الولوع الظاهر، والنظر، والعشق الواقع من القلب، والصبابة المتيمة للنفس، والفكر الطارد للنوم، والخيال الماثل للإنسان؟ أهذه كلها من آثار الطبيعة؟ أم هي من عوارض النفس؟ أم هي من دواعي العقل؟ أم من سهام الروح؟ أم هي خالية من العلل جارية على الهذر! وهل يجوز أن يوجد مثل هذه الأمور الغالبة، والأحوال المؤثرة على وجه العبث، وطريق البطل؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما سبب الاستحسان لصورة الإنسان فكمال في الأعضاء، وتناسب بين الأجزاء مقبول عند النفس.
وهذا الجواب غرضك من المسألة التي هي متوجهة نحو الصورة الإنسانية المعشوقة دون غيرها.
وأقول: إن الطبيعة مقتفية أفعال النفس وآثارها، فهي تعطي الهيولى والأشياء الهيولانية صوراً بحسب قبولها، وعلى قدر استعدادها، وتحكي في ذلك فعل النفس فيها - أعني في الطبيعة - ولكنها هي بسيطة، فتقبل من النفس صوراً شريفة تامة، فإذا أرادت أن تنقش الهيولى بتلك الصور أعجزت الأمور الهيولانية عن قبولها تامة وافية؛ لقلة استعدادها، وعدمها القوة الممسكة الضابطة ما تعطاه من الصور التامة.
وهذا العجز في الهيولى ربما كان كثيراً، وربما كان يسيراً، وبحسب قوتها على قبول الصور يكون حسن موقع ما يحصل فيها من النفس؛ فإذا المادة الموافقة للصورة تقبل النقش تاماً صحيحاً مشاكلاً لما قبلتها الطبيعة من النفس.
والمادة التي ليست بموافقة تكون على الضد.
والمثال في ذلك أن الطبيعة إنما تعمل من المادة عند تجبيل الناس
في الرحم الفطس في الأنف، والزرقة في العينين، والصهوبة في الشعر، وبحسب
قبول الهيولى الموضوعة لها، لا لأنها تقصد الصور الناقصة، بل تقصد - أبداً
- الأفضل، ولكن المادة الرطبة تأتي إلا قبول ما يلائمها، وذلك أن الدعج في
العين، والشمم في الأنف صور تحتاج إلى اعتدال المادة بين الرطوبة السيالة،
واليبوسة الصلبة، ولا يمكن إظهارها في المادة الرطبة، كما لا يمكن صياغة
خاتم من شمع ذائب.
وربما كانت المادة حاجزة من طريق الكمية دون كيفية فلا تتم الخلقة على
أفضل الهيئات.
وكذلك الحال في شعر الرأس، وأهدب العين والحاجب، فإنها لا تنتقش على ما
ينبغي إذا كانت ناقصة المادة، أو غير معتدلة في الكيفيات فتعمل الطبيعة
منها ما يمكن ويتأتى، فتجىء الصورة غير مقبولة عند النفس؛ لأنها لا تطابق
ما عندها من الكمال.
فأما وأنت تتأمل ذلك من طين الختم فإنه إذا كان ناقص الكمية غير مقدار
الخاتم، أو يابساً، أو رطباً أو خشناً - نقصت صورة الخاتم، ولم يقبل النقش
على التمام والكمال.
فأما المثال في المادة الموافقة فهو بالضد من هذا المثال؛ فلذلك تقبل ما
تعطيها الطبيعة على التمام، وتنتقش نقشاً صحيحاً مناسباً مشاكلاً لما في
النفس، فإذا رأتها النفس سرتها؛ لأنها موافقة لما عندها مطابقة لما أعطتها
الطبيعة.
فكما أن الصناعة تقتفي الطبيعة، فإذا صنع الصانع تمثالاً في مادة موافقة
فقبلت منه الصورة الطبيعية تامة صحيحة: فرح الصانع، وسر وأعجب، وافتخر؛
لصدق أثره، وخروج ما في قوته إلى الفعل موافقاً لما في نفسه، ولما عند
الطبيعة - فكذلك حال الطبيعة مع النفس؛ لأن نسبة الصناعة إلى الطبيعة في
اقتفائها إياها كنسبة الطبيعة إلى النفس في اقتفائها إياها.
ثم إن شاء من شأن النفس إذا رأت صورة حسنة متناسبة الأعضاء في الهيئات
والمقادير والألوان وسائر الأحوال، مقبولة عندها، موافقة لما أعطتها
الطبيعة - اشتاقت إلى الاتحاد بها، فنزعتها من المادة، واستثبتها في
ذاتها، وصارت إياها، كما تفعل في المعقولات.
وهذا الفعل لها بالذات، له تتحرك، وإليه تشتاق، وبه تكمل، إلا أنها تشرف
بالمعقولات، ولا تشرف بالمحسوسات.
فإذا فعلت النفس ذلك، واشتاقت إلى الطبيعيات والأجسام الطبيعة - رامت
الطبيعة في الأجساد من الاتحاد ما رامته النفس في الصور المجردة، فلا يكون
لها سبيل إليه؛ لأن الجسد لا يتصل بالجسد على سبيل الاتحاد، بل على طريق
المماسة، فتحصل حينئذ على الشوق إلى المماسة التي هي اتحاد جسماني بحسب
استطاعتها.
وهذا من النفس غلط كبير وخطأ عظيم، لأنها تنتكس من الحال الأشرف إلى الحال
الأدون، وتتصور بصورة طبيعية منها أخذت، وبها ابتديت، وتفوتها الصور
الشريفة العقلية التي ترتقي بها إلى الرتبة العليا، والسعادة العظمى.
وهذا الذي ذكرته هو الأمر الذاتي الكلي الجاري على وتيرة طبيعية تحصرها
الصناعة، وتضبطها القوانين.
فأما الاستحسان العرضي والجزئي - أعني ما يستحسنه شخص ما بحسب مزاج ما -
فهو أيضاً لأجل نسبة ما، ولكنه يصير شخصياً، والأمور الشخصية لا نهاية لها
فلذلك لا تنحصر تحت صناعة، ولا لها قانون.
والذي ينبغي أن يعلم منها أن كل مزاج متباعد من الاعتدال تكون له مناسبات
نحو أمور خاصة به، ويخالفه المزاج الذي هو منه في الطرف الآخر من الاعتدال
حتى يستقبح هذا ما يستحسن هذا، وبالضد، وكذلك ما تقيده العادات
والاستشعارات، وهو موجود في استلذاذ المأكول والمشروب؛ فإن الأمزجة
البعيدة من الاعتدال تناسب طعوماً غريبة، وتستلذ منها طرائف وعجائب.
والاستقراء يفيدك كل عجيبة وطريفة من هذا النحو في الروائح والسماع وجميع
الحواس.
مسألة لم صار الحصيف المتمكن، واللبيب المبرز يشاور
فيأتي بالفلق والداهية حتى يدع الشعر مشقوقا
والغيث مرهوقاً، فإذا انفرد بشأنه، وانتصر وتعقب غاية منافعة عاد كسراب بقيعة، لا يحلى ولا يمر حتى يفتضح عند من كان يثني الخنصر عليه بنكره ودهائه، ويشير إلى صواب رأيه؟ ما الذي أصابه ونزل به؟ وما الذي بدله وتحيف عليه؟ وما هذا الأمر الذي وسمه بما وسمه، وأداه إلى ما أداه؟.الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: سبب ذلك شيئان: أحدهما
محبة الإنسان ذاته، وتخوفه على نفسه من خطإ ينسب إليه، أو غلط يقع منه،
فتعرض له الدهشة والحيرة.
والآخر ميله إلى الهوى، والهوى عدو العقل، والخطأ - أبداً - مع الهوى،
فإذا حضر الهوى غاب العقل، وحيث يغيب العقل يغيب الخير كله؛ فالإنسان -
أبداً - أسير في يد الهوى، والهوى يريه ما يقبح جميلاً، والخطأ صواباً.
ولإحساس الرجل المميز الفاضل بذلك منه لا يأمن أن يكون رأيه لنفسه من قبل
ما يريه الهوى دون العقل، فيضطرب فكره، ولا يصح رأيه لنفسه.
فأما إذا رأى لغيره فهو سليم من الحالين جميعاً؛ فلذلك يأتي بالرأى الصحيح
السليم كالقدح لغيره.
وربما كان له هوى في غيره أيضاً، فيعرض له من الخطأ مثل ما عرض له في نفسه.
وهذا يدلك على صحة ما ذكرناه من السبب في خطئه على نفسه، وسداده في أمر
غيره.
وإذا احترز العاقل لنفسه أيضاً، وتجنب الهوى - صح رأيه لنفسه، وقل خطؤه
إلا بمقدار ما جبل عليه المرء من محبة نفسه، واشتباه الهوى في بعض المواضع
اللطيفة بالرأى الصحيح؛ فإنه حينئذ يغلط غلطاً يعذر فيه، ويسلم من تبعته.
مسألة لم يشمئز الإنسان من جرح قد فغز فوه
حتى إنه لينفر من النظر إليه، والدنو منه، وينفي خيال ذلك عن نفسه ويتعلل بغيره، وكلما اشتد نفوره منه اشتد ولوعه به؟ ما هذا أيضاً فإنه باب آخر في طي التعجب مما تقدم؟ وفي المسألة: أن المعالج يباشر ذاك بعينه نظراً، وبيده علاجاً، وبلسانه حديثاً أترى ذاك من المعالج إنما هو لضراوته وعادته وطول مباشرته وملاحظته؟ أم لمكسبه وحاجته وعياله ونفقته؟ فإن كان للضراوة والعادة فما خبره في ابتداء هذه الضروة والعادة؟ وإن كان لحرفته فكيف عاند طباعه معاندة وجاهد نفسه مجاهدة؟ وهل يستوى للإنسان أن يعتاد ما ليس في طبعه ولا في عادته، ثم يستمر ذلك عليه، ويكون كمن ولد فيه، وعمر به؟.الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد تبين في المباحث الفلسفية أن النفس بالحقيقة واحدة، وإنما تكثرت بالأشخاص، وإذا كان ذلك كذلك فالإنسان إذا رأى بغيره أمراً خارجاً عن الطبيعية من جرح، أو تفاوت في الخلق، أو من نقص في الصورة - عرض له من ذلك ما يعرض له في ذاته، وكأنه ينظر إلى نفسه وجسمه؛ لأن النفس هناك هي بعينها النفس ههنا، فبحق ما يعرض هذا العارض.
فأما ولوعه به، وحضوره في ذكر أبداً، فإنما ذلك لأجل أن النفس إذا قبلت صورة نزعتها من مادتها، واستثبتتها في ذاتها، وقيدت عليها قوة الذكر.
وليس تجري النفس مجرى المرآة التي إذا قابلها الشيء قبلت صورته ما دام ذلك الشيء قبالتها، فإذا زال زالت صورته عنها، ولا كناظر العين في قبول الصور أيضاً؛ وذلك أن هذه أجسام طبيعية تقبل صورة الأجرام قبولاً عرضياً فأما النفوس فإنها تقبل الصور بنوع أشرف وأعلى، ثم تستثبت تلك الصورة وإن زال حاملها عن محاذاة العين.
وقد مر في هذه المسائل طرف من هذا المعنى، وبين هناك كيف تقبل النفس بقوتها المتخيلة صورة الشيء سريعاً، وكيف تبقى بعد ذلك هذه الصورة في قوتها الذكرية حتى تراها مناماً ويقظة؛ فإنا متى شئنا أحضرنا صور آبائنا وأجدادنا ومدننا حتى كأننا نراهم، وإن كانوا غائبين أو منقرضين.
فأما لم ذلك، وكيف استقصاء الكلام فيه فموجود في مظانه.
وأما المعالج لما سألت عنه، المعتاد به بالضراوة؛ فإنما كان ذلك لأجل تكرر الصورة، وأن ذلك الفعل صار كالخلق له.
وقد بينا فيما تقدم أن الصور إذا تكررت على النفس حصل منها شيء ثابت كالجوهري لها، وقلنا إنه لولا هذه الحال لما أدبنا الأحداث، ولا دعونا الصبيان في أول نشوئهم العادات الجميلة؛ فإن الأفعال إذا اتصلت ودامت ألفتها النف سواء كانت حسنة أو قبيحة.
فإذا استمر الإنسان عليها صارت ملكة له وقنية، فعسر زوالها.
مسألة ما العلة في حب العاجلة
؟ألا ترى الله - تعالى - يقول: " بسم الله الرحمن الرحيم " كلا بل تحبون العاجلة " صدق الله العظيم " ، والشاعر يقول:
والنفس مولعة بحب العاجل.
ومن أجل هذا المعنى ثارت الفتن واستحالت الأحوال وحارت العقول،
واحتيج إلى الأنبياء، والسياسة، والمقامع، والمواعظ، فإذا كان حب العاجلة
طباعاً، ومبذوراً في الطينة، ومصوغاً في الصيغة، فكيف يستطاع نفيه
ومزايلته؟ وكيف يرد التكليف بخلاف ما في الطبيعة؟ أليست الشريعة مقوية
للطبيعة؟ أليس الدين قوام السياسة؟ أليس التألة قضية العقل؟ أليس المعاد
نظير المعاش؟ فكيف الكلام في هذا الشق؟ وكيف يطرد العتب على من أحب ما
حببت إليه، وقصرت همته عليه، كما خلق ذكراً أو أنثى، أو طويلاً أو قصيراً،
أو ضريراً، أو بصيراً، أو جلفاً، أو شهماً؟ فإن سقط اللوم في إحدى
الحاشيتين سقط في التي تليها، وإن لزم في إحداهما لزم في أخرهما.
وهذا نظر ينسل إلى الجبر والاختيار، وهما فنان يحتاجان إلى تحديد نظر،
وتجديد اعتبار.
والحال المقسمة للبال من قضاء الوطر، وبلوغ الغاية فقي النظر.
الجواب: قال أوب علي مسكويه - رحمه الله: العاجلة إنما يومأ بها إلى
الحواس وتوابعها من اللذات في المآكل والمشارب، والاستفراغات، والاستراحات.
والتي تختص بهذه الأشياء من الحواس هي النفس البهيمية.
ثم ينبغي أن تعلم أن هذه النفس هي معنا من أول النشوء، ومع الولادة، فقد
ألفناها إلفاً قوياً مع الزمان المتصل الطويل، فلذلك كانت قوتها أظهر،
وغلبتها أشد، وصار الحكم لها.
وإنما نظرنا النفس المميزة بقوة العقل من بعد، فيظهر أثرها قليلاً قليلاً
إلى أن يقوى في وقت التكهل والاجتماع، وبلوغ الأشد، فنحن نحتاج لذلك إلى
مقاومة تلك النفس، والاستعداد لها، وكسر حدتها، وإيهان قوتها بكلفة شديدة،
وصبر طويل بحسب قوتها، واستيلائها علينا، وإلفنا إياها، ونحتاج أيضاً إلى
تقوية النفس الناطقة بامتثال أمرها، وتثميرها، وتنفيذ عزائمها؛ فلأجل هذا
صعب علينا قبول أمر هذه، وسهل قبول أمر تلك.
فأما قولك: كيف يرد التكليف بخلاف ما في الطبيعة؟ فإنا نقول: إن طبيعة
النفس البهيمية الانقياد للنفس الناطقة، والوقوف عند أمرها.
ولولا أن ذلك في جلبتها وسوسها، وهو قبول التأديب، وأن تصدر أفعالها
الخاصة بها بحسب ما يأمرها به العقل - لكان - لعمري - تكليفاً بخلاف ما في
الطبع، ولكن أحداً لا يروم إبطال هذه القوة رأساً، بل يطالبها بأن تقبل
ترتيب الأفعال على ما يرسمه العقل، وهي مطبوعة على قبول هذا الأدب كما
قلنا.
وليس يجري هذا مجرى ما ضرب به المثل من الطول والقصر وغيرهما؛ لأن هذا شيء
لا صنع فيه للأدب؛ وإنما هو أثر يقبل الهيولى من المعطي بحسب موضوعه، ولا
يمكن خلافه بوجه ولا سبب.
وتفسير ذلك أن الرطوبة التي في المادة تقبل من الحرارة امتداداً وانجذاباً
إلى العلو الذي هو حركة الحرارة، فيحدث الطول بحسب المادة، وبقدر الرطوبة
المنفعلة، والحرارة الفاعلة.
ولا يمكن أن يكون إلا على ما يظهر بالفعل.
فقد بان الفرق بين هذين النوعين اللذين رمت الجمع بينهما، وظهر السبب في
حب العاجلة، وحسن ما أدب الله - تعالى - به الناس بالدين والآداب، وخرج
الجواب عن المسألة في إيجاز وإيضاح.
مسألة ترى ما السبب في قتل الإنسان نفسه
عند إخفاق يتوالى عليه، وفقر يحوج إليه، وحال تتمنع على حوله وطوقه، وباب ينسد دون مطلبه ومأربه، وعشق يضيق ذرعاً به، ويبعل في معالجته؟.وما الذي يرجو بما يأتي؟ وإلى أي شيء ينحو فيما يقصد وينوي؟ وما الذي ينتصب أمامه، ويستهلك حصافته، ويذهله عن روح مألوفة، ونفس معشوقة، وحياة عزيزة؟ وما الذي يوهمه من العدم حتى يسلبه من قبضة الوجدان، ويسلمه إلى صرف الحدثان؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: الإنسان مركب من ثلاث قوى نفسانية، وهو كالواقف بينها تجذبه هذه مرة، وهذه مرة.
وبحسب قوة إحداها على الأخرى، يميل بفعله، فربما غلبت عليه القوة الغضبية، فإذا انصبغ بها، وما بفعله إليها ظهرت قوته كلها كأنها غضب، وخفيت القوى الأخرى حتى كأنها لم توجد له، وكذلك إذا هاجت به القوة الشهوية خفيت آثار القوى الأخر.
وأحصف ما يكون الإنسان، وأحسنه حالاً إذا غلبت عليه القوة الناطقة؛ فإن هذه القوة هي المميزة العاقلة التي ترتب القوى الأخرى حتى تظهر أفعالها بحسب ما تحده وترسمه.
والإنسان حينئذ نازل بالمنزلة الكريمة بحيث هيأه الله تعالى، وكما أراده.
فإذا كان الأمر كذلك فغير منكر أن يهيج بالإنسان بعض تلك القوى
منه عند التواء أمر عليه، أو انسداد باب دون مطلب له، فيظهر منه فعل لا
توجبه روية، ولا يقتضيه تمييز؛ لخلفاء أثر القوة الناطقة، واستيلاء القوة
الأخرى.
وأنت تجد ذلك عياناً عند الأحوال المختلفة بك؛ فإنك تجد نفسك في أوقات على
أحوال مؤثرة لها، قاصدة إليها، غير مصغية إلى نصيح، ولا قابلة أمر سديد،
حتى إذا أفقت من تلك السكرة التي غلبت عليك في تلك الحال - عجبت من
الأفعال التي ظهرت منك، وأنكرت نفسك فيها، وكأن غيرك كان الذي آثرها، وقصد
إليها، فلا تزال كذلك حتى تهيج بك تلك القوة الأولى مرة أخرى، فلا يمنعك
ما جربته من نفسك، ووعظتها به - أن تقع في مثله.
وسبب ذلك التركيب من القوى المختلفة النفسانية.
وليس يمكن الإنسان أن يخلص بقوة واحدة، ويصدر أفعال الباقية بحسب التي هي
أفضل وأشرف إلا بعد معالجة شديدة، وتقويم كثير، وإدمان طويل؛ فإن العادة
إذا استمرت، والعزيمة إذا أنفذت في زمان متصل طويل - حصل منها خلق، فكان
الحكم له، وصار هو الغالب؛ ولذلك نأمر الأحداث بالسيرة الجميلة، ونؤاخذهم
بالآداب التي تسنها الشرائع، وتأمر بها الحكمة.
واستقصاء هذا الكلام، وذكر علله لا تقتضيه المسألة، ولا يفي به المكان.
فإن شك فيما قلنا شاك، وظن أن الإنسان المركب من القوى الثلاثة يجب أن
يكون لا زماً لأمر واحد متركب من تلك القوى كما نجد الحال في سائر
المعجونات والمركبات من الطبيعة، فليعلم أن مثاله ليس بصحيح؛ لأن قوى
الإنسان النفسانية، لها من ذاتها حركات تزيد وتنقص، وأحوال - أيضاً -
تهيجاً.
وليست كذلك قوى الطبيعيات، فلتنعم النظر في ذلك تجده كما أومأنا إليه
وذكرناه.
مسألة سألت بعض مشايخنا بمدينة السلام
عن رجل اجتاز بطرف الجسر، وقد اكتنفه الجلاوزة لا يسوقونه إلى السجن ، فأبصر موسى وميضة في طرف دكان مزين، فاختطفها كالبرق، وأمرها على حلقومه، فإذا هو يخور في دمائه، قد فارق الروح وودع الحياة.فقلت: من قتل الإنسان؟ فإذا قلنا: قتل نفسه، فالقاتل هو المقتول، أم القاتل غير المقتول؛ فإن كان أحدهما غير الآخر، فكيف تواصلا مع هذا الانفصال؟ وإن كان هذا ذاك، فكيف تفاصلا مع هذا الاتصال؟ وإنما شيعت المسألة الأولى بهذا السؤال لأنه ناح نحوها، وقاف أثرها.
الجواب: قال أبو على مسكويه - رحمه الله: كأن هذه المسألة مبينة على أن الإنسان شيء واحد لا كثرة فيه، والشبهة فيها من هذا الوجه تقوى، فإذا بان أن للإنسان قوى كثيرة وهو مركب منها، وأنه يميل في وقت ما نحو قوة، وفي وقت آخر نحو غيرها، وأن أفعاله - أيضاً - بحسب ميله إلى إحدى القوى، وغلبتها عليه، كما بيناه في المسألة التي قبل هذه - زال هذا الشك.
فأما قوله: كيف تواصلا مع هذا الانفصال؟ فأقول: إن السبب في ذلك أن الباري تعالى لما علم أن هذا المركب من نفس وجسد يحتاج إلى أشياء تقيمه من غذاء وغيره، وأنه لا قوام لحياته إلا بمادة، وكان لا يصل إلى تلك المادة إلا بحركة وسعي، وكانت العائقات والمانعات عنها كثيرة - أعطاه قوة يصل بها إلى حاجاته، ويدفع بها أضدادها عن نفسه؛ ليتم له البقاء.
ومن شأن هذه القوة أن تهيج وتثور في أوقات بأكثر مما ينبغي، وفي أوقات تقصر عما ينبغي.
وهاتان الحالتان لها رذيلتان: أما الأولى فيتبعها التهور، وأما الثانية فيتبعها الجبن.
وللإنسان - بقوة التمييز والعقل - أن يستعمل هذه القوة على ما ينبغي، وبالقدر الذي ينبغي، وعلى الشيء الذي ينبغي.
فإذا حصل في هذه الرتبة فهو شجاع وممدوح، وكما أراده الله تعالى منه على خلقه له.
وقد بقي في المسألة موضع شك، وهو أن يقول قائل: إن كان قاتل نفسه إنما ظهر منه هذا الفعل بحسب القوة الغضبية فهو شجاع، والشجاع محمود، ونحن نعلم أن هذا الفاعل بنفسه هذا الفعل مذموم، فكيف حاله؟ وأين موضع الشجاعة الممدوح؟ فنقول: لعمري إن هذا الفعل من أثر القوة الغضبية، ولكنه بحسب رذيلتها، وتقصيرها عما ينبغي، لا بحسب الزيادة، ولا بحسب الاعتدال الذي سميناه شجاعة؛ وذلك أن المرء الذي يخاف أمراً فيه من فقر أو شدة، ولا يرحب ذرعاً به، ولا يستقبله بعزيمة قوية، ومنه تامة - جبان ضعيف، فيحمله هذا الجبن على أن يقول: أستريح من تحمل هذه المشقة التي ترد علي.
وهذا هو النكول والضعف المسمى جبناً.
وقد ذكرنا أن قوة الغضب ربما كلت، ونقصت عما ينبغي، فتكون رذيلة ومنقصة،
ولا تسمى شجاعة، ولا يكون صاحبها محموداً ولا ممدوحاً.
مسألة كيف صار يخلص في وقت معتاد النفاق
؟ويتيقن من اشتمل بالريب، ويستيقظ من هو راقد، ويتنصح من هو غاش؟ وكيف صار - أيضاً - ينافق من نشأ على الإخلاص، ويريب من ألف النزاهة؟ وعلى هذا كيف يكون يخون من استمر على الأمانة ستين عاماً ويتحرج من عتق في الخيانة ستين عاماً؟ ما هذه العوارض المختلفة، والعادات المستطرقة؟ وكذلك نجد الكذاب يصدق أحياناً لغير أرب مجتلب، والصادق يكذب لغير معنى محدد، ثم لا يتفق أن يصدق ذلك في نافع، أو يكذب هذا في دافع.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذه المسألة أيضاً قريبة من المسألتين المتقدمتين، والجواب عنها قريب من الجواب عنهما.
وذلك ان النفاق والنصح، وسائر ما ذكره في هذه المسألة هو من آثار النفس الناطقة.
ومن البين أن هذه النفس لها أيضاً مرض وصحة؛ فصحتها اعتدالها في قواها الباقية، ومرضها خروجها عن الاعتدال.
وهي إن خرجت عن اعتدالها في وقت فغير منكر لها أن تعود إليه في وقت آخر، وكما أن الصدق، والنصيحة، وصحة الروية، وتقسيط الأعمال بحسب الأحوال هو صحتها واعتدالها، فأضداد هذه مرضها وخروجها عن الاعتدال.
ولكن ليس نسلم أنها تصدق ثم تكذب لغير سبب، ولا لدفع مضرة، بل يظن - أبداً - أن فعلها صواب لأمر تراه، فربما كان ذلك الظن غلطاً وخطأ، فأما أن تفعل ذلك لغير أرب، وفير قصد إلى ما تراه خطأ فمحال.
مسألة ما معنى قول بعض العلماء إن الله عم الخلق بالصنع
ولم يعمهم بالاصطناع؟ وما مبسوط هذا المعنى؟ وكيف وجه تحصيله؟ وهل ترك الله - تعالى - فيه صلاح الخلق فلم يجد به ابتداء من غير طلب؟ كيف يكون هذا وقد بدأ بالنعم قبل الاستحقاق، وخلق الخلق من غير حاجة إلى الخلق؟ فإن قيل: أبلى بالحاجة ثم منع من غير بخل، قيل: فلن ينبغي أن يجحد إحسانه فيما ظهر لحيرة تقع فيما يظن، ولعل في غيب ما منع ما قد يقع، ولكنه مجهول، وهو بتدبيره ملىء، وعلى موجب الحكمة ماض بغير مدافعة، ولا اعتراض.الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما قول من قال: إن الله - تعالى - عم بالصنع خلقه، ولم يعمهم بالاصطناع فكلام قد ذهب به مذهب البلاغة، ومعناه صحيح لولا التكلف الذي تجشمه صاحبه.
وهذا المعنى في قول المسيح - عليه السلام - أظهر، وذاك أنه روى لنا، ونقل من لغته إلى لعتنا أنه قال: " لا تهمتوا ولا تقولوا ما نأكل، وما نشرب، وما نلبس؟ فإن قدر الحاجة قد عم به جميع الخلق، وإنما يلتمسون الفضول فيها، واعلموا أن ليس كل من دعا إلى الله يرى وجه الله، بل من أكمل رضوانه بالعمل الصالح " .
فهذا قول المسيح - عليه السلام - على ما نقل وروى.
فأما تفسير هذا الكلام، وهو تبيين الكلام الأول الذي سألت عن معناه، فإن الصنع البين الظاهر لجميع الخلق هو إعطاؤهم الحياة، ثم إزاحة العلة فيما هو ضروري في بقائها، وذلك أن بقاءها بالحرارة الغريزية، وبقاء الحرارة الغريزية بالترويح يخرج من معدنها الذي هي متعلقة به - الدخان الذي يحدث عن الحرارة والرطوبة الدهنية، وتبديل الهواء اليابس بذلك الدخان بهواء آخر رطب سليم موافق لمادة تلك الحرارة، وذلك بمنفاخ دائم العمل في شبيه بكير الحدادين وهو الرئة، وآلة النفس في جميع ماله قلب ومعدن لهذه الحرارة وما يجرى مجراها في الحيوانات الأخرى التي لا قلب لها، ولا حاجة بها إلى الترويح عن الحرارة الملتهبة في المادة الرطبة الدهنية، ثم إزاحة العلة في نفس الهواء الذي هو مادة تلك الحرارة، ثم في الرطوبة التي لولاها لفني مقدار ما في الجسم منها مع اغتذاء الحرارة بها، أعني الماء.
وهذه هي الأشياء الضرورية في الحياة التي لو فقد منها واحد طرفة عين لبطلت الحياة.
وقد أزيحت العلة فيها إزاحة بينة كثيرة ظاهرة وعم بها جميع الحيوان.
فأما الأشياء التي تتبع هذه مما هي ضرورية في طول بقاء الحي، وفي
حسن حاله من العروق الضوارب وغير الضوارب، وآلات الغذاء، والقوى الجاذبة
والمغيرة، والمحيلة الممسكة والدافعة، وارئيسة من هذه القوى، والخادمة
لها، وقيام الرئيسة - أبداً - بسياسة الخوادم واستخدامها، وقيام الخوادم
منها بالطاعة والخدمة الدائمة - فأمر قد تبين في صناعة الطب، وظهر ظهوراً
لا يحتاج معه إلى استئناف قول.
ويبقى بعد ذلك تخير الحي لقوت دون قوت مما ليس بضروري في بقائه، فقد أعطى
بحسب حاجته - أيضاً - قوة يطيق بها التخير والتوصل إلى قدر حاجته.
وهذا كله معموم به جميع الخلق، غير ممنوع من شيء منه.
فأما الاصطناع فهو القرب من الباري - جل اسمه - وليس يتم هذا إلا بسعي
ورغبة وتوجه.
وقد دل - أيضاً - تقدس اسمه إلى ذلك، وبقي أن يتحرك العبد إلى هذه الحال؛
فإنه لا يمنع - أيضاً - من الاصطناع، بل الباب مفتوح، والحجاب مرفوع،
وإنما المرء يحجب نفسه، ويمتنع من التوجه والرغبة، وقصد المنهاج والسبيل
الذي دل عليه، ورغب فيه - بأن يتشاغل بفضول عيشه الذي هو مستغن عنه بما هو
حي، وبالميل إلى لذات الحس التي تعوقه عن مطلبه وغايته ومنتهى سعادته.
وهذا بحسب الموضع كاف فيما سألت عنه، والله الموفق.
مسألة ما سر النفس الشريفة في إيثار النظافة
ومحبة الطهارة، وتتبع الوضاءة
؟وعلى هذا فما وجه الخير في قوله صلى الله عليه وسلم " البذاذة من الإيمان " ؟ وقال بعض النساء: القشف من الشرف، والترف من السرف.
وسمعت صوفياً يقول: سر الصوفي إذا صفا لم يحتمل الجفا.
ومطلق هذا يقتضي قيداً، ولكن قال هذا وسكت.
وسمعت فيلسوفاً يقول: إذا صفا السر انتفى الشر.
وهذا وإن كان قولاً رشيقاً، فإن السبب فيه متوار، والدليل عنه متراخ.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: ينبغي أن نتكلم أولاً في سبب النظافة والدنس حتى تبين معنى كل واحد منهما، ثم ننظر في نفور الإنسان عن الدنس، وميله إلى الطهارة فأقول: إن العناصر الأربعة إذا لم تمتزج ضروب الامتزاجات المتغايرة لم ينفر الإنسان منها، ولم يسمها دنساً، وإنما يقع النفور من بعض المزاجات.
وإذا نظرنا في المزاجات وجدنا هذه الأربعة إذا اختلطت ضرباً من الاختلاط على مناسبة ما كانت معتدلة، وحصل المزاج الإنساني، وهذا المزاج له غرض ما، فكل ما لم يخرج عنه فهو إنسان بالصورة والمزاج، وإن انحرف عن هذا المزاج، وخرج عنه - لم يكن إنساناً.
ولا بد أن يكون انحرافه وخروجه إلى واحد من هذه الأربعة أكثر، فإن كان مائلاً إلى جهة الحرارة، وباقي العناصر مقاربة للمزاج الإنساني، أو باقية بحالها - نظر في مقدار خروجه إلى جهة الحرارة، فإن كان كثير جداً كان سماً للإنسان قاتلاً له، وإن كان دون هذا كان ضاراً له بحسب خروجه عن اعتداله في الحرارة، وهذا لا يسمى دنساً، وكذلك إن خرج في جهة اليبوسة والبرد، فإن هذه إن أفرطت، وحصلت مضادة للمزاج المعتدل حتى تبطله - كانت سموماً، وإن لم تبطل ذلك المزاج فهي تضره وتغيره عن صورته، وسواء كان هذا الخارج عن الاعتدال الإنساني نباتاً أو حيواناً فإنه يعرض فيه ما ذكرناه.
فهذه حال مفردات العناصر إذا أفرطت مع اعتدال الباقيات.
فإما إذا خرج اثنان منها عن الاعتدال، فإن خروجهما أيضاً يكون على ضروب وأنحاء إلا أن الرطوبة - خاصة - إذا أفرطت في الزيادة، والحرارة إذا أفرطت في الزيادة - عرض من هذا المزاج حال تسمى عفونة وهي عجز الحرارة عن تحليل الرطوبة فيحصل مخالفاً للمزاج المعتدل من هذا الوجه فيتكرهه الإنسان، ويأباه سواء أكان ذلك في حيوان أو جماد.
وهذا النفور والتكره على ضروب بحسب خروج المزاج المقابل له عن
الاعتدال، وسأضرب لذلك مثلاً، وهو أن مزاج الإنسان لما كان مقارباً لمزاج
الفرس، وكانت بينهما مناسبة - حصل بينهما قبول من تلك الجهة، فإذا تباعد
هذا المزاج حتى يكون منه الغبار والدود والجعل والذباب - نفر منه الإنسان
وتكرهه، وذلك أن هذه الأنواع من الحيوانات مكونة من عفونات - كما وصفناه
من زيادة الرطوبة، ونقصان الحرارة - فبعدت من مزاج الإنسان، وكذلك حال
فضول البدن؟ وذلك أن الطبيعة إذا استولت على الغذاء فتناولت منه القدر
الملائم، وميزته أيضاً وحصلته في أوعيته، وشبهته أولاً أولاً بالبدن؛ ونفت
ما ليس بملائم، وميزته أيضاً، وحصلته في أوعية أخرى، وهي آلات النفض، فإن
ذلك المميز الذي قد خرج عنه جميع ما فيه من الملاءمة - يحصل على غاية
البعد من المشابهة، وتعرض له غلبة الرطوبة، ونقصان الحرارة، فيعفن، فينفر
عنه الإنسان ويكرهه، ويحب الراحة منه.
وهذا سبيل ما يرشح من البدن من سائر الفضول، فإن جميعه ما نفاه الطبع
وميزه، فهو لذلك غير ملائم، وما لم يكن ملائماً كان متكرهاً، ويسمى هذا
النوع دنساً إلا أنه ما دام مستبطناً وغير بارز من البدن، فهو محتمل
بالضرورة، فإذا برز عفناه - حينئذ - وتكرهناه، وتقررنا منه.
وهذه الأشياء هي التي تسمى دنساً وقذراً بالطبع.
وههنا أشياء أخر ينفر منها الإنسان بالعادة، ويألفها أيضاً بالعادة، وليس
ما نحن فيه من هذه المسألة في شيء.
فأما قول النبي - عليه السلام - " البذاذة من الإيمان " ، فهو بعيد من هذا
النمط الذي كنا في ذكره؛ فإن من كاد باذ الهيئة يكره الدنس، ويحب النظافة،
وليس يخالفك في شيء مما تؤثره من معنى الطهارة، فإن خالفك فليس من حيث
بذاذة الهيئة، لكن كما يخالفك غيره ممن ليس بباذ الهيئة.
وكذلك حال التقشف الذي حكيت فيه كلاماً ما عن بعض الصوفية؛ فإن تلك
المعاني هي موضوعات أخر ليست مما كنا فيه، والكلام فيها يتصل بمعاني العفة
والقناعة، والاقتصاد، وهي فضائل قد استقصى الكلام فيها في مواضع أخر.
فأما قول القائل: سر الصوفي إذا صفا لم يحتمل الجفا، وقول الآخر: إذا صفا
السر انتفى الشر، فهو إيماء إلى مراتب النفس من المعارف، ومنازل اليقين.
ولعمري إن من حصل له مرتبة في القرب من بارئه - جل اسمه، وتعالى علواً
كبيراً - فقد انتفى منه الشيء، ولم يحتمل الجفاء.
وشرح هذا الكلام وبسطه طويل، وقد لاح مما ذكرناه ما فيه كفاية وبلاغ.
مسألة الغناء أفضل أم الضرب
؟والمغنى أفضل وأشرف أم الضارب؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما الموسيقا فإنه علم، وقد يقترن به عمل، وعامله يسمى موسيقاراً.
فأما علمه فهو أحد التعاليم الأربعة التي لا بد لمن يتفلسف أن يأخذ بخط منه، وأما عمله فليس من التعاليم، ولكنه تأدية نغم وإيقاعات متناسبة من شأنها أن تحرك النفس - في آلة موافقة، وتلك الآلة إما أن تكون من البدن، أو خارجة عن البدن.
فإن كانت من البدن فهي أعضاء طبيعية أعدت لتكمل بها أمور أخر فاستعملت في غيرها.
وإن كانت خارجة من الطبيعة فهي آلات صناعية أعدت لتكمل بها تأدية النغم والإيقاع.
ومن شأن الآلات الطبيعية إذا هي استعملت في غير ما أعدت له - أن تضطرب، وتخرج عن أشكالها، فتتبذل وتتغير.
فإن كان غرض المتكلف ذلك فيها الوصول إلى خسائس الأمور ونقائصها كان قبيحاً مستهجناً.
وإن كان غرضه منها إظهار أثر العلم للحس، ليتبين النسب المؤلفة في النفس، وإظهار الحكمة في ذلك - كان جميلاً مستحسناً، وإن كان لا بد فيه من الخروج عن العادة والإلف عند قوم، لكن غرض أهل زماننا من العمل هو إثارة الشهوات القبيحة، وإعانة النفس البهيمية على النفس المميزة حتى تتناول لذاتها من غير ترتيب العقل، وترخيصه فيها.
وإذا كان قصده لذلك بآلات طبيعية فهو - لا محالة - يضم إليه كلاماً ملائماً له، يؤلف منه تلك النغم في ذلك الإيقاع.
فإن كان - أيضاً - منظوماً نظماً شعرياً غزلياً قد استعمل فيه خدع الشعر وتمويهاته - تركب تحريكه للنفس، وكثرت وجوهه، واشتدت الدواعي، وقويت على ما ينقض العفة، ويثير الشبق والشره؛ لأن الشعر وحده يفعل هذه الأفعال.
وهذه أسباب شرور العالم، وسبب الشر شر؛ فلذلك يعافه العقل،
وتخطره الشريعة، وتمنع منه السياسة.
فإذا كانت الآلة خارجة من البدن فأحسنها ما قل استعمال الأعضاء فيه، وبقيت
هيئة الإنسان ونصبته صحيحة، غير مضطربة، وكان مع ذلك أكثر طاعة في إبراز
على التأليف، وأقدر على تمييز النغم، وأفصح على حقائق النغم المتشابهة لا
إلى المتناسبة التي حصلها على الموسيقا.
ولسنا نعرف أكمل في هذه الأسباب من الآلة المسماة عوداً؛ لأن أوتارها
الأربعة مركبة على الطبائع الأربع، ولدساتينها المشدودة نسب موافقة لما
يراد من تمييز النغم فيها، وليس يمكن أن توجد نغمة في العالم إلا وهي
محكية منها، ومؤادة بها.
فأما ما يحكى عن الأرغن الرومي فلم تسمعه إلا خبراً، ولم نره إلا مصوراً،
وقد عمل فيه الكندي وغيره كلاماً ما لم يخرج به إلى الفعل من القوة، ولو
عملت الآلة لا حتاجت من مهارة مستعملها ما يتعذر وجوده ويبعد.
وكما أن العود لما خرج إلى الفعل احتيج إلى ماهر يضربه ولم يكن ليغني فيه
العلم دون العمل والحذق فيه، فكذلك هذه الآلة لو خرجت إلى الفعل؛ فلذلك
توقفنا عن الحكم لها بالشرف، وقطعناه للعود.
مسألة ما علة افتتان بعض الناس في العلوم
على سهولة من نفسه، وانقياد من هواه واستجابة من طبعه، وآخر لا يستقل بفن مع كد القلب، ودوام السهر، ومواصلة المجالس، وطول المدارسة؟.ولعل الأول كان من المحاويح، والثاني من المياسير.
وقال بعض الناس: هذه مواهب.
وقال آخرون: هي أقسام.
وقال قائلون: هي طبائع مختلفة، وعروق نزاعة، ونفوس أباءة.
وقال آخرون: إنما هي تأثيرات علوية، ومقابلات سفلية، واقترانات فلكية.
وقال آخر: الله أعلم بخلقه وبفعله، ليس لنا إلا النظر والاعتبار، فإن أفضينا بنا إلى البيان فنعمة لا يقوم بشكرها إنس ولا جان، وإن أديا إلى اللبس فتسليم لا عار فيه على الإنسان.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن النفس وإن كانت في ذاتها كريمة شريفة فإن أفعالها إنما تصدر بحسب آلتها، فكما أن النجار إذا فقد الفأس، واستعمل المثقب أو المنشار مكانه لم يصدر فعله الذي يتم بالفأس كاملاً، ولم تحصل له صور المنجور تاماً، ولم يكن ذلك لتقصير منه، بل لفقد الآلة - فكذلك حال النفس إذا ثارت إلى معرفة، ونهضت نحو علم، ثم لم تجد آلته، فإنها حينئذ بمنزلة النجار الذي ضربناه مثلاً، وذلك أن بعض العلوم يحتاج فيه إلى تخيل قوى، والتخيل إنما يكون باعتدال ما في مزاج بطن الدماغ المقدم.
وبعض العلوم يحتاج فيه إلى فكر صحيح، والفكر الصحيح إنما يتم باعتدال ما في مزاج بطن الدماغ الأوسط.
وبعض العلوم يحتاج فيه إلى حفظ صحيح جيد، والحفظ الجيد يحصل باعتدال ما في مزاج بطن الدماغ المؤخر.
وبعض هذه المزاجات يحتاج في اعتداله الخاص فيه إلى رطوبة ما، وبعضه يحتاج فيه إلى يبوسة ما، وكذلك الحال في الكيفيتين الأخريين.
ولما كانت هذه البطون متجاورة أدى بعضها إلى بعض كيفيتها؛ فإن رطوبة أحدها ترطب الآخر بالمجاورة وإن كان غير محتاج إلى الرطوبة في اعتداله الخاص به، فلذلك قل من يجتمع له الفضائل الثلاث من صدق التخيل، وصحة الفكر، وجودة الحفظ.
وإذا غلب أحد هذه كانت سهولة العلم الموافق لذلك المزاج على الإنسان بحسب ما ركب فيه، وأعطى القدرة عليه.
ومن فقد الاعتدال فيها كلها فقد الانتفاع بالعلوم أجمعها.
وربما حصلت الفضائل في التركيب من صحة المزاج، ثم أهمل صاحبها نفسه بمنزلة النجار الذي يجد الآلة ثم لا يستعملها كسلاً وميلاً إلى الراحة والهوينا، وشغلاً باللعب والعبث، فهذا هو المذموم المضيع حظه، الذي خسر نفسه، قال الله تعالى فيه " بسم الله الرجمن الرحيم " قل إن الخاسرين الذي خسروا أنفسهم " صدق الله العظيم " .
فأما من استعمل آلته بحسب طاقته، وحصل فضيلتها بنحو استطاعته فهو معذور.
وليس يكون ذلك بيسار ولا فقر، بل بحصول الآلة، ومواتاة المزاج وبقدر عناية الإنسان بعد ذلك.
فمن قال من الناس: إنها مواهب، أو أقسام، أو طبائع، أو تأثيرات
علوية أو غير ذلك فهو صادق، وليس يكذب أحد في شيء مما حكيته؛ لأن كل واحد
منهم يومىء إلى جهة صحيحة، وسبب ظاهر، وإن كانت جميع الجهات والأسباب
مرتقية إلى سبب واحد لا سبب له، وإلى علة أولى هي علة الباقيات وإلى مبدع
للجميع، خالق للكل - تعالى ذكره، وتقدس إسمه - ونحن نستمده التوفيق،
ونسأله العصمة؛ ونستوزعه الشكر، ونفوض إليه أمورنا وهو حسبنا ومولانا،
وعليه توكلنا، ونعم المولى، ونعم النصير.
مسألة ما الفراسة؟ وماذا يراد بها؟
وهل هي صحيحة، أم هي تصح في بعض الأوقات دون بعض؟ أو لشخص دون شخص؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: الفراسة صناعة تتصيد الأخلاق
والأفعال التي بحسب الأخلاق، من الأمزجة والهيئات الطبيعية، والحركات التي
تتبعها.
وهي صناعة صحيحة، قوية الأصول، وثيقة المقدمات، ويحتاج صاحبها ومتعاطيها
أن يتدرب في ثلاثة أصول لها حتى يحكمها، ثم يحكم بها، فإنه حينئذ لا يخطىء
ولا يغلط.
والأصول الثلاثة هي هذه: أما أحدها، فالطبائع الأربع أنفسها.
والثاني، الأمزجة وما يتبعها ويقتضيها.
والثالث، الهيئات والأشكال والحركات التابعة للأخلاق.
ونحن نشرحها على مذهبنا في الإيجاز والإيماء إلى النكت، والدلالة بعد ذلك
على مظانها.
فأما قولك: فما الذي يراد بها؟ فإن المراد من هذه الصناعة تقدمة المعرفة
بأخلاق الناس ليلابسهم على بصيرة.
والفراسة قد تكون في الخيل والكلاب وسائر الحيوانات التي ينتفع بها الناس،
وقد تكون في الجمادات أيضاً كفراسة السيوف والسحاب وغيرهما، إلا أن
العناية التامة إنما وقعت بفراسة الإنسان خاصة لكثرة الانتفاع به مما
سنذكره بمشيئة الله.
وأما قولك: هل تصح أبداً، أم في وقت دون وقت، ولشخص دون شخص؟ فإني أقول:
إنها تصح أبداً في كل وقت، ولكل أحد، ولكن على الشريطة التي ذكرناها من
إحكام الأصول التي وعدنا بذكرها مجملة، والدلالة على مواضعها مفصلة.
وإنما قلنا إنها تصح أبداً ودائماً، لأن مقوماتها ودلائلها ثابتة غير
منقلبة، وليست كأشكال الفلك التي تتبدل وتتغير، بل شكل الإنسان، وهيئاته،
ومزاجه، والحركات اللازمة له عن هذه الأشياء ثابتة باقية ما دام حياً،
فالمستدل بها أيضاً يتصفحها فيجدها بحال واحدة.
ونعود إلى ذكر الأصول الثلاثة فنقول: أما الاستدلال بالطبائع أنفسها فهو
أن الحرارة التي تكون في قلب الإنسان - وهي سبب الحياة - من شأنها إن زادت
على الاعتدال أن تزيد في النفس؛ لحاجة القلب إلى الترويح بالرئة، وأن توسع
التجويف الذي تكون فيه بالحركة الزائدة، وأن يكون لها دخان فاضل على القدر
المعتدل بحسب زيادتها، وبقدر الرطوبة الدهنية التي تجاورها.
فيعرض من هذه الأحوال التي ذكرتها أن يكون الإنسان الذي حرارة قلبه بهذه
الصفة عظيم النفس، واسع الصدر، جهير الصوت، كثير الشعر في نواحي الصدر
والأكتاف إذا لم يمنع منه مانع، كما يعرض لمن يكون جلده مستحصفاً، ومسام
جلده مسدودة أو ضيقة.
فمن وجد هذه الصفات فحكم بأن الموجب لها حرارة غالبة فهو صادق، إلا أنه لا
ينبغي أن يتسرع إلى حكم آخر حتى في الأصلين الباقيين، ليثق كل الثقة، وذلك
أن الحرارة يتبعها الغضب والشجاعة، وسرعة الحركة، ولكن على شروط، وهي أن
للدماغ مشاركة في أفعال الإنسان، وتعديل حرارة القلب إذا كان بارداً
رطباً، فينبغي أن ينظر فيه، فإن كان صاحب هذا المزاج صغير الرأس بالإضافة
إلى صدره فاحكم عليه بما قلناه.
فإن أضاف المستدل إلى هذه الدلالة الدلالتين الأخريين من الأصلين الباقيين
لا أشك في صحة حكمه، وصدق قياسه.
وأنا الاستدلال بالأصل الثاني وهو المزاج، فقد علمنا أن لكل مزاج خلقاً
ملائماً، وشكلاً موافقاً، وذلك الخلق يتبعه خلق النفس؛ فإن الطبيعة تعمل -
أبداً - من كل مزاج خلقاً خاصاً؛ فلذلك لا تعمل من نطفة الحمار إلا
حماراً، ومن النواة إلا النخلة، ومن البرة إلا براً.
وكذلك أيضاً - أبداً - تعمل من المزاج المخصوص بالأسد خلقة
الأسد، ومن مزاج الأرنب خلقة الأرنب، وأن ذلك الخلق يتبعه خلق خاص - أبداً
- بموجب الطبيعة؛ وذلك أن الأسد لما كان مزاج قلبه حاراً تتبعه الجرأة،
ولأنه مستعد لأن يلتهب قلبه - صار يسرع إليه الغضب، ولأن مزاجه موافق
لخلقه أعدت له الطبيعة آلة الفرس والنهس، وأزاحت علته في الأعضاء التي
يستعملها بحسب هذا المزاج، وأعطته الأيد والبطش.
ولما كان مزاج الأرنب مقابلاً لهذا المزاج صار خواراً جباناً ضعيفاً قليل
المنة فأعدت الطبيعة له آلة الهرب، فهو لذلك خفيف جيد العدو، لا يصدر عنه
شيء من أفعال الشجاعة والإقدام، فكل أسد شجاع مقدام، وكل أرنب جبان فرار،
حتى لو تحدث إنسان أن أرنباً أقدم على سبع وولى السبع عنه لكان موضع ضحك.
فإذا وجد صاحب الفراسة في مخايل الإنسان وخلقه مشابهة لأحد هذين الحيوانين
فحكم له بقريب من ذلك المزاج والخلق الصادر عنه فهو غير بعيد من الحق لا
سيما إن أضاف إليه الأصلين الباقيين.
وهذا المثالان اللذان ذكرناهما يستمر القياس عليهما على مزاج خاص بحيوان
أعني أنه يتبع كل مزاج خلق كالروغان للثعلب والخداع، والجبن للأرنب
والختل، وكالملق للسنور والأنس، وكالسرق للعقعق والدفن.
وإنما صار الإنسان وحده لا يظهر منه الخلق الطبيعي ظهوراً تاماً كظهوره من
هذه الحيوانات لأنه مميز، ذو روية، فهو يستر على نفسه مذموم الأخلاق
بتعاطي ضده، وتكلف فعل المحمود، وإظهار ما ليس في طبعه، ولا في جبلته
فيحتاج حينئذ إلى أن يستدل على خلقه الطبيعي بأحد شيئين: إما بطول الصحبة،
وتفقد الأحوال وإما بالاستدلال الذي نحن في ذكره، والاستعانة بصناعة
الفراسة على ما يسيره من أخلاقه الطبيعية.
فإن كان مزاجه وخلقه مناسباً لخلق الأرنب حكم بخلقه، وإن كان مناسباً
للأسد حكم عليه بخلقه مع سائر دلائله الأخر.
فأما الاستدلال بالأصل الأخر، وهو الهيئات والأشكال والحركات فهو أن كل
حال من حالات النفس من غضب ورضا، وسرور وحزن، وغير ذلك هيئات وحركات
وأشكالاً تتبع تلك الحال أبداً، وظهورها يكون في العين والوجه أكثر،
وأصحاب الفراسة يعتمدون العين خاصة، ويزعمون أنها باب القلب، فيتصيدون من
شكلها ولونها وأحوال أخر لها كثيرة يضيق موضعنا عن ذكرها - أكثر الأخلاق
والشيم، وتحسن إصابتهم، ويصدق حكمهم لا سيما إن أضافوا إليه الأصلين
الباقيين؛ وذلك أن عين المسرور مثلاص، وعين الحزين ظاهرتا الهيئة والحركة،
فإذا وجد الإنسان وهو بالخلقة والطبيعة على أحد هاتين الحالتين من هيئة
عينه وحركتها حكم عليه بذلك الطبع، وكذلك من ظهر في وجهه في حال سكوته
قطوب، وغضون في الجبهة وعبوس - حكم عليه بهذا الطبع، وأنه سيىء الخلق.
فهذه هي الأصول الثلاثة التي اعتمدها أصحاب الفراسة وهي قوية طبيعية كما
تراها.
وقد عمل فيها أفليمون كتاباً.
ويقال إنه أول من سبق إلى هذا العلم ممن انتهى إلينا أثره، وعرفنا خبره،
ثم تبعه جماعة صنفوا فيه كتباً، وهي مشهورة فمن أحب الاتساع في هذا العلم
فليأخذه من مظانه.
وههنا نوع آخر من الاستدلال - وإن لم يكن طبيعياً فهو قريب منه - وهو
العادات؛ فإن المثل قد سبق بأن العادة طبيعة ثانية، وقد علمنا أن من نشأ
بمدينة، وفي أمة، وطالت صحبته لطائفه - تشبهبهم، وأخذ طريقتهم، كمن يصحب
الجند، وأصحاب الملاهي، أو سائر طبقات الناس، حتى يظن بمن صحب البهائم
طويلاً أنه يحدث فيه شيء من أخلاقها.
وأنت تبين ذلك في الجمالين والرعاة الذين يسكنون البر، وتقل مخالطتهم
للناس، وفي القوم الذين يعاملون النساء والصبيان، كيف ينحطون إلى أخلقهم،
ويتشبهون بهم.
فهذه جملة من القول في الفراسة.
وينبغي أن تحذر الحكم بدليل واحد، وتتوخى جميع الدلائل من الأصول الثلاثة؛
لتكون بمنزلة شهود عدول لا يتداخلك الشك في صدقهم، فيكون حكمك صادقاً،
وفراستك صحيحة، وذلك بحسب دربتك بالصناعة بعد معرفتك بالأصول.
وما أكثر الانتفاع بهذا العلم وأحضره؛ فإني أرى في الجولان الذي يتفق لي
في الأرض، وكثرة الأسفار أن أرى ضروباً من الناس، وأخالط أخياف الأمم،
وأشاهد عجائب الأخلاق فأستعمل الفراسة، فيعظم نفعها، وتتعجل فائدتها.
والفراسة ربما تخطىء في الفيلسوف التام الحكمة ووجه ذلك أنه ربما كان ذا مزاج فاسد، وخلق - بالطبع - مشاكل له، فيصلحه، ويهذبه بطول المعاناة، وتعاهد نفسه بدوام السيرة الحميدة، ولزوم السجايا الرضية، كما يحكي عن أفليمون، وهو أول من سبق إلى هذا العلم، فإنه حمل إلى أبقراطيس وهو متنكر فدخل إليه وهو لا يعرفه، فلما تأمله حكم عليه: زان، فهم أصحابه بالوثوب عليه، فنهاهم أبقراطيس وقال: قد صدق الرجل بحسب صناعته، ولكني بالقهر أمنع نفسي من إظهار سجيتها.
مسألة ما سر قولهم الإنسان حريص على ما منع
؟ولم صار هذا هكذا؟ وكيف يسرع الملل مما بذل، ويضاعف الولوع بطلب ما بخل به؟ هلا كان الحرص في مقابلة ما وجد، والزهد في مقابلة ما منع؟ ولهذا ما صار الرخيص مرغوبا عنه، والغالي مرغوباً فيه، ولهذا إذا ركب الأمير لا يحرص على رؤيته كما يحرص على رؤية الخليفة إذا برز.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن النفس غنية بذاتها، مكتفية بنفسها، غير محتاجة إلى شيء خارج عنها.
وإنما عرض لها الحاجة والفقر إلى ما هو خارج منها لمقارنتها الهيولى، وذلك أن أمر الهيولى بالضد من أمر النفس في الفقر والحاجة، والإنسان لما كان مركباً منها عرض له التشوف إلى تحصيل المعارف والقنيات.
أما العارف والعلوم فهو يحصلها في شبيه بالخزانة له، يرجع إليه متى شاء، ويستخرج منه ما أراد، أعني القوة الذاكرة التي تستودع الأمور التي تستفاد من خارج، أعني من العلماء والكتب، أو التي تستثار بالفكر والروية من داخل .
وأما القنيات والمحسوسات فإنه منها ما يروم من تلك التي تقدم ذكرها فلذلك يغلط فيها، ويخطىء في الاستكثار منها إلى أن يتنبه بالحكمة على ما ينبغي أن يقتني من العلوم والمحسوسات فيقصد نحو القصد من الأمرين جميعاً، ويقف عنده.
وإنما حرص على ما منع لأنه إنما يطلب ما ليس عنده، ولا هو موجود له في خزانته فيتحرك لاقتنائه وتحصيله بحسب ميله إلى أحد الأمرين، أعني المعقول أو المحسوس، فإذا حصله سكن من هذه الجهة، وعلم أنه قد ادخره، ومتى رجع إليه وجده، إن كان مما يبقى بالذات، وتشوف إلى جهة أخرى، ولا يزال كذلك إلى أن يعلم أن الجزئيات لا نهاية لها، وما ما لا نهاية له فلا طمع في تحصيله، ولا فائدة في النزاع إليه، ولا وجه لطلبه، سواء كان في المعلوم أو في المحسوس.
وإنما ينبغي أن يقصد من المعلومات إلى الأنواع والذوات الدائمة السرمدية الموجودة أبداً بحالة واحدة، ويكون ذلك برد الأشخاص التي بلا نهاية إلى الوحدة التي يمكن أن تتأحد بها النفس، ومن المحسوسات المقتناة إلى ضرورات البدن ومقيماته دون الاستكثار منها؛ فإن استيعاب جميعها غير ممكن لأنها أمور لا نهاية لها.
فإذن كل ما فضل عن الحاجة، وقدر الكفاية فهو مادة الأحزان والهموم والأمراض، وضروب المكاره.
والغلط في هذا الباب كثير، وسبب ذلك طمع الإنسان في الغنى من معدن الفقر؛ لأن الفقر هو الحاجة، والغنى هو الاستقلال، اعني ألا يحتاج بتة؛ ولذلك قيل أنه الله - تعالى - غني؛ لأنه غير محتاج بتة.
فأما من كثرت قنياته فإنه ستكثر حاجاته بحسب كثرة قنياته وعلى قدر منازعته إلى الاستكثار تكثر وجوه فقره، وقد تبين ذلك في شرائع الأنبياء، وأخلاق الحكماء.
فأما الشيء الرخيص الموجود كثيراً فإنما رغب عنه لأنه معلوم أنه إذ التمس وجد، وأما الغالي فإنما يقدر عليه في الأحيان ويصيبه الواحد بعد الواحد، فكل إنسان يتمنى أن يكون ذلك الواحد؛ ليحصل له ما لم يحصل لغيره، وذلك من الإنسان على السبيل الذي شرحناه من أمره.
مسألة ما سبب نظر الإنسان في العواقب
؟وما مثاره منها؟ وما آثاره فيها؟ وما الذي يحلى به إذا استقصى؟ وما الذي يتخوفه إذا جنح إلى الهويني؟ أو ما مراد الأولين في قولهم: المحتفل ملقي، والمسترسل موقى؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: أما نظر الإنسان في العواقب فيكون لأمرين.
أحدهما لتطلعه إلى الأمور الكائنة، وشوقه إلى الوقوف على الأمر الكائن قبل حدوثه، لما تقدم فيه من الكلام في المسألة الأولى.
والآخر لأخذ الأهبة له إن كان مما ينفع فيه ذلك؛ ولهذا المعنى
اشتاق الإنسان إلى الفأل والزجر إذا عدم جميع وجوه الاستدلال من أشكال
الفلك، إلى الفأل والزجر إذا عدم جميع وجوه الاستدلال من أشكال الفلك،
وحركات النجوم، وربما عدل إلى المتكهن، وصدق بكثير من الظنون الباطلة.
وأما قول المتقدمين: المحتفل ملقي، والمسترسل موقي فهو على ظاهره كالمناقض
للحكم الأول؛ ولذلك أن الإشارة في هذا المثل هو إلى أن المحتفل إنما يتوقى
ما لا بد أن يصيبه، فهو يجتهد أن يخرج من حكم القضاء أعني موجبات الأقدار
بتوسط حركات الفلك، فيصير اجتهاده في الخروج منه سبباً لحصوله فيه، ووقوعه
عليه.
وإلى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله:
وإذا حذرت من الأمور مقدراً ... وهربت منه فنحوه تتوجه
فأما المسترسل إلى ذلك، الراضي به فإنه موقى مما هو غير مقضي، ولا هو
بمصيب له وإن لم يتوقه، كما قال الشاعر فيمن كان بغير هذه الصفة:
حذراً أموراً لا تكون وخائف ... ما ليس منجيه من الأقدار.
ويتصل بهذا الباب شرح ما يجب أن يتوقى، وما يجب ألا يتوقي، أعني بذلك ما
يغني فيه الفكر والروية، وما لا يغني فيه.
وإذا مر ما يقتضيه من الكلام استقصيته إن شاء الله.
مسألة ما يصيب الإنسان من قرينه في خيره وشره
؟وكيف صار يؤثر الشرير في الخير أسرع مما يؤثر الخير في الشرير؟ وما فائدة النفس في المقارنة؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: ينال القرين من قرينه الاقتداء والتشبه، وكما أن كل متجاورين من الأشياء الطبيعية لا بد أن يؤثر أحدهما في الآخر فكذلك حال النفس؛ وذاك أن الطبيعة متشبهة بالنفس؛ لأنها شبيهة بظل النفس، ومن شأن الشيء الأقوى في الطبيعة أن يحيل الأضعف إلى نفسه ويشبهه بذاته، كما تجد ذلك في الحار والبارد، والرطب واليابس؛ ولأجل تأثير المجاور في مجاوره حدثت الأمراض في البدن، وبسببه عولج بالأدوية.
ولما كانت النفس التي فينا هيولانية صار الشر لها طباعاً، والخير تكلفاً وتعلما، فاحتجنا - معاشر البشر - أن نتعب بالخير حتى تستفيده ونقتنيه، ثم ليس يكفينا تحصيل صورته حتى نألفه، ونتعوده، ونكرر زماناً طويلاً الحالة التي حصلت لنا منه على أنفسنا؛ لتصير ملكة وسحية بعد أن كانت حالاً.
فأما الشر فلسنا نحتاج إلى تعب به، وتحصيله، بل يكفي فيه أن نخلى النفس وسومها، ونتركها على طبيعتها، فإنها تخلو من الخير، والخلو من الخير هو الشر؛ لأنه قد تبين في المباحث الفلسفية أنه ليس الشر بشيء له عين قائمة، بل هو عدم الخير؛ ولذلك قيل: الهيولى معدن الشر وينبوعه لأجل خلوها من جميع الصور، فالشر الأول البسيط هو عدم، ثم يتركب، وسبب تركبه الأعدام التي هي مقترنة بالهيولى.
وشرح هذا الكلام طويل، إلا أن الذي يحصل لك من جواب المسألة فيه أن النفس تتشبه بالنفس المقارنة لها، وتقتدي بها، والشر أسرع إليها من الخير؛ وهو أن النفس التي فينا هي هيولانية، وأعني بهذا القول أنها قابلة للصور من العقل، فالمعقولات إنما تصير معقولات لنا إذا ثبتت صورها في النفس، ولذلك قال أفلاطون: إن النفس مكان للصور.
واستحسن ارسططاليس هذا التشبيه من أفلاطون؛ لأن استعارة حسنة، وإيماء فصيح إلى المعنى الذي أراده.
فيجب - على هذا الأصل - أن نتوقى مجالسه الأشرار، ومخالطتهم، ومقارنتهم، ونقبل قول الشاعر:
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينة ... فإن القرين بالمقارن مقتد
وينبغي أن نأخذ الأحداث والصبيان به أشد الأخذ فقد مر في مسألة ما يحقق هذا المعنى، ويؤكده، وينبه عليه.
مسألة ما وجه تسخيف من أطال ذيله وسحبه
وكبر عمامته، وحشا زيقه قطناً وعرض جيبه تعريضاً، ومشى متبهسناً، وتكلم متشادقاً؟ ولم شنع هذا ونظيره؟ وما الذي سمج هذا وأمثاله؟ ولم لم يترك كل إنسان على رأيه واختياره، وشهوته وإيثاره؟ وهل أطبق العقلاء المميزون، والفضلاء المبرزون على كراهة هذه الأمور إلا لسر خاف، وخبيئة موجودة؟ فما ذلك السر؟ وما تلك الخبيئة؟.الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: ينكر مما ذكرته كله
التكلف، وذاك أن من خالف عادات الناس في زيهم، ومذاهبهم، وتفرد من بينهم
بما يباينهم، ثم احتمل مؤونة ما يتجشمه، فليس ذلك منه إلا لغرض مخالف
لأغراضهم، وقصد لغير ما يقصدونه: فإن كان غايته من هذه الأشياء أن يشهر
نفسه، وينبه على موضعه فليس يعدو أن يوهم بها أمراً لا حقيقة له، ويطلب
حالاً لا يستحقها؛ لأنه لو كان يستحقها لظهرت منه، وعرفت له من غير تكلف
ولا تجشم لهذه المؤن الغليظة، فإذن هو كاذب فعلاً، ومزور باطلاً وما تعاطي
ذلك إلا ليغر سليماً، ويخدع مسترسلاً.
وهذا مذهب المحتال الذي يتحرز منه، ويتباعد عنه.
هذا إلى ما يجمعه من بديهة المخالفة، والمخالفة سبب الاستيحاش، وعلة
النفور، وأصل المعاداة.
وإنما حرص الناس وأهل الفضل، وحرص لهم الأنبياء عليهم السلام بما وضعوه
لهم من السنن والشرائع؛ لتحدث بينهم الموافقة والمناسبة التي هي سبب
المحبات، وأصل المودات؛ ليتشاركوا في الخيرات، ولتحصل لهم صورة التأحد
الذي هو سبب كل فضيلة، ولأجله تم الاجتماع في المدنية الذي هو سبب حسن
الحال في العيش والاستمتاع بالحياة والخيرات المطلوبة في الدنيا.
مسألة ما ملتمس النفس في هذا العالم؟ وهل لها ملتمس وبغية؟
وإن وسمت بهذه المعاني خرجت من أن تكون علية الدرجة، خطيرة القدر؛ لأن هذا
عنوان الحاجة، وبدء العجز.
ولولا أن يتسع النطاق لسألت: ما نسبتها إلى الإنسان؟ وهل لها به قوام، أو
له بها قوام؟ وإن كان هذا فعلى أي وجه هو؟ وأوسع من هذا الفضاء حديث
الإنسان؛ فإن الإنسان قد أشكل عليه الإنسان.
ثم حكيت حكايات ليس لها غناء في المسألة، فلنشتغل بالجواب.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: لولا لفظة الالتماس توهم غير
المعنى الصحيح في حال النفس، وظهور آثارها في هذا العالم لأطلقتها، ورخصت
فيها لك كما أطلقها قوم، ولكني رأيت أبا بكر محمد بن زكريا الطبيب وغيره
ممن كان في طبقته قد تورطوا في مذهب بعيد من الحق، سببه هذه اللفظة وما
أشبهها مما أطلقته الحكماء على سبيل الاتساع في الكلام، بل لأجل الضرورة
العارضة للألفاظ عند ضيقها عن المعاني الغامضة التي أطلقوا عليها.
ولكني سأشير لك إلى ما ينبغي أن تعتقده في هذا الباب وهو أن الطبائع إذا
امتزجت ضروب الامتزاجات بضروب حركات الفلك حدثت منها ضروب الصور والأشكال
التي تعملها الطبيعة، وتقبل من آثار النفس بوساطة الطبيعة ضروب الآثار؛
لأن النفس تظهر آثارهما في كل مزاج بحسب قبوله، وتستعمل كل آلة طبيعية
بحسب ملاءمتها في كل ما يمكن أن تستعمل فيه، وتنهيه إلى أقصى ما يمكن أن
ينتهي إليه من الفضيلة.
وهذا الفعل من النفس لا لغرض أكثر من ظهور الحكمة، وذاك أن ظهور الحكمة من
الحكيم لا يكون لغرض آخر فوق الحكمة؛ لأن أجل الأفعال ما لم يرد الشيء
آخر، بل ذاته، وكل فعل أريد لغاية أخرى، ولشيء آخر فذلك الشيء أجل من ذلك
الفعل.
ولا يمكن أن يكون ذلك ماراً بلا نهاية، فالغاية الأخيرة، والفعل الأفضل ما
لم يفعل لشيء آخر، بل هو بعينه الغاية والغرض الأقصى، ولذلك ينبغي ألا
يكون قصد المتفلسف بفلسفته شيئاً آخر غير الفلسفة، ولا يجب أن يكون قصد
فاعل الجميل شيئاً آخر غير الجميل، أعني أنه لا يجب أن يقصد به نيل منفعة،
ولا طلب ذكر، ولا بلوغ رئاسة، ولا شيئاً من الأشياء غير ذات الجميل لأنه
جميل.
وقد أشار الحكيم إلى أن النفس تكمل في هذا العالم بقبولها صور المعقولات
لتصير عقلاً بالفعل بعد أن كانت بالقوة، فإذا عقلت العقل صارت هي هو؛ إذ
من شأن المعقول والعاقل أن يكونا شيئاً واحداً لا فرق بينهما.
فأما حديث الإنسان الذي شكوت طوله، وحكيت من الكلام المتردد الذي
لم يفدك طائلاً، فالذي ينبغي أن تعتمد عليه هو أن هذه اللفظة موضوعة على
الشيء المركب من نفس ناطقة وجسم طبيعي؛ لأن كل مركب من بسيطين أو أكثر
يحتاج إلى اسم مفرد يعبر عن معنى التركيب، ويدل عليه كما فعل ذلك بالصورة
التي تجتمع مع مادة الفضة فسمى خاتماً، وكما تجتمع صورة السرير مع مادة
الخشب فيصير اسمه سريراً، وعلى هذا أيضاً يفعل إذا اجتمع جسمان طبيعيان أو
أجسام طبيعية فتركب منها شيء آخر فإنه يسمى باسم مفرد، كما يفعل بالخل إذا
تركب مع العسل أو السكر فيسمى سكنجبناً، وكما تسمى أنواع الأدوية
والمعجونات من الأخلاط الكثيرة، وأنواع الأغذية والأشربة المركبة ينفرد كل
واحد منها باسم خاص، وكذلك يفعل بالمادة التي تستحيل من صورة إلى صورة
كعصير العنب الذي يسمى عصيراً مرة، وخمراً مرة، وخلا مرة بحسب تبدل الصورة
على الموضوع الواحد.
فالإنسان هو النفس الناطقة إذا استعملت الآلات الجسمية التي تسمى بدناً
لتصدر عنها الأفعال بحسب التمييز.
مسألة حكيت - أيدك الله - حكايات بين سائل ومتكلم
ولم تتوجه إلى مطلوب ينبغي أن نبحث عنه؛ لأن المسألة من باب الأسماء والصفات، وقد تكلمنا عليه فيما مضى كلاماً مستقصى لا وجه لإعادته، فينبغي أن تعود إلى ما مضى، وتطلبه؛ لتجده كافياً بمعونة الله.مسألة ما سبب استشعار الخوف بلا مخيف
؟وما وجه تجلد الخائف والمصاب كراهة أن يوقف منه على فسولة طبعه، أو قلة مكانته، أو سوء جزعه، هذا مع تخاذل أعضائه، وندائه على ما به، واستحالة أعراضه، ووجيب قلبه، وظهور علامات ما إذا أراد طيه ظهر على أسرة وجهه، وألحاظ عينيه، وألفاظ لسانه، واضطراب شمائله؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: سبب ذلك توقع مكروه حادث، فإن كان السبب صحيحاً قوياً، والدليل واضحاً جلياً كان الخوف في موضعه.
وإن لم يكن كذلك، وكان من سوء ظن، وفساد فكر فهو مرض أو مزاج فاسد من الأصل.
ثم بحسب ذلك المكروه يحسن الصبر، ويحمد احتمال الأذى العارض منه وتظهر من الإنسان أمارات الشجاعة أو الجبن.
وأثبت الناس جناناً وجأشاً، وأحسنهم بصيرة وروية لا بد أن يضطرب عند نزول المكروه الحادث به، الطارىء عليه، لا سيما إن كان هائلاً؛ فإن أرسططاليس يقول: من لم يجزع من هيج البحر وهو راكبه، ومن الأشياء الهائلة التي فوق طاقة الإنسان فهو مجنون.
وكثير من المكاره يجري هذا المجرى ويقاربه، والجزع لا حق بالمرء على حسبه ومقداره: فإن كان المكروه والمتوقع مما يطيق الإنسان دفعه أو تخفيفه فذهب عليه أمره، واستولى عليه الجزع، ولم يتماسك له - فهو جبان جزوع مذموم من هذه الجهة.
ودواؤه التدرب باحتمال الشدائد وملاقاتها، والتصبر عليها، وتوطين النفس لها قبل حدوثها؛ لئلا ترد عليه وهو غافل عنها، غير مستعد لها.
وإذا كانت الشجاعة فضيلة، وكانت ضدها نقيصة ورذيلة؛ فمن لا يحب أن يستر نقيصته، ويظهر فضيلته، مع ما تقدم من قولنا فيما سبق.
إن كل إنسان يعشق ذاته، ويحب نفسه؟.
مسألة ما سبب غضب الإنسان وضجره
إذا كان مثلاً يفتح قفلاً فيتعسر عليه حتى يجن، ويعض على القفل، ويكفر، وهذا عارض فاش في الناس؟.الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذا العارض وشبهه من أقبح ما يرض للإنسان، وهو غير معذور، إن لم يصلحه بالخلق الحسن المحمود؛ وذلك أن الغضب إنما يثور به دم القلب لمحبة الانتقام، وهذا الانتقام إذا لم يكن كما ينبغي، وعلى من ينبغي، وعلى مقدار ما ينبغي فهو مذموم، فكيف به إذا كان على الصورة التي حكيتها.
فأما سؤالك عن سبب الغضب فقد ذكرته وأجبت عنه، وإذا أثار في غير وضعه فواجب على الإنسان الناطق المميز أن يسكنه، ولا يستعجله، ولا يجري فيه على منهاج البهيمة، وسنة السبع؛ فإن من أعانة بالفكرة، وألهبه بسلطان الروية حتى يحتدم ويتوقد فإنه سيعسر بعد ذلك تلافيه وتسكينه، والإنسان مذموم به إذا وسوم الطبيعة، ولم يظهر فيه أثر التمييز، ومكان العقل.
وجالينوس قد ذكر في كتاب الأخلاق حديث القفل بعينه، وتعجب من جهل
من يفعل ذلك، أو يرفس الحمار ويلكم البغل، فإن هذا الفعل يدل على أن
الإنسانية يسيره في صاحبه جداً، والبهيمية غالبة عليه، أعني سوء التمييز
وقلة استعمال الفكر.
وليس هذا وحده يعرض لحشو الناس وعامتهم، بل الشهوة والشبق وسائر عوارض
النفس البهيمية والغضبية إذا هاج بهم، وابتدأ في حركته الطبيعية لم
يستعملوا فيه ما وهبه الله - تعالى - لهم، وفضلهم به، وجعلهم له أناسي،
اعني أثر العقل بحسن الروية، وصحة التمييز، والله المستعان، ولا قوة إلا
به.
مسألة لم صار من كان صغير الرأس خفيف الدماغ
؟ولم يكن كل من كان عظيم الرأس رزين الدماغ
؟الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: يحتاج الدماغ إلى اعتدال في الكيفية والكمية، فإن حصل له احدهما لم يغن عن الآخر، فإن كان جوهره جيداً في الكيفية، وكانت كميته ناقصة فهو - لا محالة - ردىء، وإن كانت كميته كثيرة فليس هو - لا محالة - رديئاً، فقد يكون كثيراً وجيد الجوهر إلا أنه يجب أن يكون مناسباً لحرارة القلب؛ ليحصل بين برد هذا ورطوبته، وحرارة ذلك ويبوسته - الاعتدال المحبوب المحمود.
ومتى حصل على الخروج من هذا الاعتدال تبعه من الرداءة قسطه ونصيبه، إلا أن التفاضل بين أنواع الخروج من الاعتدال كثير، ولأن يكون جيداً وكثيراً زائداً على قدر الحاجة خير من ان يكون جيداً وناقصاً عن قدر الحاجة، فإن جمع رداءة الكيفية والكمية كان صاحبه معتوهاً مخبلاً بحسب ذلك.
مسألة لم اعتقد الناس في الكوسج أنه خبيث وداهية
وكذلك في القصير
؟ولم يعتقدوا العقل والحصافة فيمن كان طويل اللحية، كثيف الشعر، مديد القامة، جميل الإمة ولم رأوا خفة العارضين من السعادة؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذه المسألة من باب الفراسة.
والممدوح المحمود من كل أمر يتبع مزاجاً ما هو الاعتدال.
فأما الطرفان اللذان يكتنفان الاعتدال - أعني الزيادة والنقصان - فهما مذمومان مكروهان.
فإن كان وفور اللحية وطولها وعظمها وذهابها في جميع جهات الوجه دليل السلامة والغفلة؛ فبالواجب صار الطرف الذي يقابله من الخفة والنزرة والقلة دليل الخبث والدهاء.
وهما جميعاً طرفان خارجان عن الاعتدال المحمود.
وأحسب أن للاختيار السيء مدخلاً: وذلك أن الرجل إذا كان وافر إضاعة اللحية فهو قادر على أن يخفف منها بأيسر مئونة حتى يحصل على القدر المعتدل، والهيئة المحمودة، فتركه إياها على الحال المذمومة مع تعبه بها، وإصلاحها دائماً، أو تركه إياها حتى تسمج وتضطرب دليل على سوء اختيار، ورداءة تمييز.
فأما عدم اللحية فليس يقدر صاحبه على حيلة فيها فهو معذور.
مسألة لم سهل الموت على المعذب
مع علمه أن العدم لا حياة معه، وليس بموجود فيه، وأن الأذى - وإن اشتد - فإنه مقرون بالحياة العزيزة؟ هذا وقد علم أيضاً أن الموجود أشرف من المعدوم، وانه لا شرف للمعدوم، فما الذي يسهل عليه العدم؟ وما الشيء المنتصب لقلبه؟ وهل هذا الاختيار منه بعقل أو فساد مزاج؟.الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذه المسألة - وإن كان الغرض فيها صحيحاً فالكلام فيها مضطرب غير مسلم المقدمات، وذلك أن الإنسان إذا مات فليس يعدم رأساً، بل إنما تبطل عنه أعراض، وتعدم عنه كيفيات، فأما جواهره، فإنها غير معدومة، ولا يجوز على الجوهر العدم بتة؛ لما تبين في أصول الفلسفة من أن الجوهر لا ضد له، ومن أشياء أخر ليس هذا موضعها.
فالجوهر لا يقبل العدم من حيث جوهر، وأجزاء الإنسان إذا مات تنحل إلى أصولها - أعني العناصر الأربعة، وذلك بأن يستحيل إليها.
فأما ذوات الجواهر فهي باقية أبداً.
وأما جوهره الذي هو النفس الناطقة فقد تبين أنه أحق بالجوهرية من عناصره الأربعة، فهو إذن دائم البقاء أيضاً.
ولما لم تكن مسألتك متوجهة إلى هذا المعنى، وإنما وقع الغلط في
أخذ مقدمات غير صحيحة، وإرسال الكلام فيها على غير تحرز - وجب أن ننبه على
موضع الغلط، ثم نعدل إلى جواب الغرض من المسألة فنقول: إن الحياة ليست
بعزيزة إلا إذا كانت جيدة، وأعني بالحياة الجيدة ما سلمت من الآفات
والمكاره، وصدرت بها الأفعال تامة جيدة، ولم يلحق الإنسان فيها ما يكرهه
من الذل السديد، والضيم العظيم، والمصائب في الأهل والولد.
وذلك أن الإنسان لو خير بين هذه الحياة الرديئة، وبين الموت الجيد، أعني
أن يقتل في الجهاد الذي يذب به عن حريمه، ويمتنع به عن المذلة والمكاره
التي وصفناها؛ لوجب بحكم العقل والشريعة أن يختار الموت والقتل في مجاهدة
من يسومه ذلك.
وهذه مسألة قد سبقت لها نظيرة، وتكلمنا عليها بجواب مقنع، وهو قولك: ما
سبب الجزع من الموت؟ وما سبب الاسترسال إلى الموت؛ فليرجع إليه فإنه كاف.
مسألة لم ذم الإنسان ما لم ينله، وهجن ما لم يحزه
؟وعلى ذلك عادى الناس ما جهلوا حتى صار هذا من الحكم اليتيمة: وقد عادى الناس ما جهلوا كما قيل فلم عادوه؟ ولم لم يحبوه ويطلبوه ويفقهوه حتى تزول العداوة، ويحصل الشرف، ويكمل الجمال، ويحق القول بالثناء، ويصدق الخبر عن الحق؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: هذا من قبيح ما يعترى الناس من الأخلاق، وهو جار مجرى الحسد، وذاهب في طريقه.
وصاحب المثل الذي يقول: المرء عدو ما جهل، إنما أخرجه مخرج الذم والعيب كما قيل: الناس شجرة بغي وحسد.
والسبب في محبة النفس أولاً، ثم الغلط في تحصيل ما يزينها.
وذلك أنه إذا أحب الإنسان نفسه أحب صورتها، والعلم صورة النفس، ويعرض من محبة صورة نفسه أن يبغض ما ليس له بصورة، فمتى حصل له علم أحبه، وإذا لم يحصل له أبغضه.
ويذهب عليه التماس ما جهله بالمطلب - وإن كان فيه مشقة - أولى به؛ ليصير - أيضاً - صورة أخرى له جميلة.
ولعل المانع له من ذلك كراهة التذلل لمن يتعلم منه بعد حصول العز له في نوع آخر، وبين طائفة أخرى.
فأما قولك؛ فلم لم يحبوه حتى يطلبوه ويفقهوه؟ فهو الواجب الذي ينبغي أن يفعل، وعليه حض صاحب المثل بالتنبيه على العيب ليتجنب بإتيان الفضيلة.
وسمعت بعض أهل العلم يحكي عن قاض جليل المحل، عالى المرتبة أنه هم بتعلم الهندسة على كبر السن.
قال: فقلت له: ما الذي يحملك على ذلك وهو يقدح في مرتبتك، ويطلق ألسن السفهاء عليك، وأنت لا تصل إلى كبير حظ منه مع علو السن، وحاجة هذا العلم إلى زمان طويل، وذكاء لا يوجد إلا مع الحداثة واستقبال العمر؟ فقال: ويحك! أحسست من نفسي بغضاً لهذا العلم، وعداوة لأهله فأحببت أن أتعاطاه لأحبه، ولئلا أبغض علماً فأعادي اهله.
وهذا هو الانقياد للحق، وتجرع مرارته حرصاً على حلاوة ثمرته، ورياضة للنفس على ما تكرهه فيما هو أزين لها، وأعود عليها، وحملها على ما يصلحها ويهذبها.
مسألة لم كان الإنسان إذا أراد أن يتخذ عدة أعداء
في ساعة واحدة قدر على ذلك، وإذا قصد اتخاذ صديق ومصافاة خذن واحد لم يستطع إلا بزمان واجتهاد وطاعة وغرم؟ وكذلك كل صلاح مأمول، ونظام مطلوب في جميع الأمور، ألا ترى أن الفتق أسهل من الخياطة، والهدم أيسر من البناء، والقتل أخف من التربية والأحياء؟.الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: جواب مسألتك هذه منها.
وما أشبهها بحكاية سمعتها عن الأصمعي، وذاك أنه بلغني أن قارئاً قرأ عليه: الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا فقال: يا أبا سعيد: ما الألمعى؟ فقال: الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا.
فأنا قائل في هذه المسألة أيضاً: إنما صار الإنسان قادراً على اتخاذ الأعداء بسرعة، وغير قادر على اتخاذ الأصدقاء إلا في زمان طويل، وبغرامة كثيرة - لأن هذا فتق، وذاك رتق، وهذا هدم، وذاك بناء.
وسق باقي كلامك فإنه جوابك.
مسألة ما الذي حرك الزديق والدهري على الخير
وإيثار الجميل، وأداء الأمانة، ومواصلة البر، ورحمة المبتلي، ومعونة الصريخ، ومغثة الملتجيء إليه، والشاكي بين يديه؟ هذا وهو لا يرجو ثواباً، ولا ينتظر مآباً، ولا يخاف حساباً.أترى الباعث على هذه الأخلاق الشريفة، والخصال المحمودة رغبته في
الشكر، وتبرؤه من القرف، وخوفه من السيف؟ قد يفعل هذه في الأوقات لا يظن
به التوقى، ولا اجتلاب الشكر، ما ذاك إلا لخفية في النفس، وسر مع العقل.
وهل في هذه الأمور ما يشير إلى توحيد الله تبارك وتعالى؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: للإنسان - بما هو إنسان - أفعال
وهمم وسجايا وشيم قبل ورود الشرع، وله بداية في رأيه، وأوائل في عقله لا
يحتاج فيها إلى الشرع؛ بل إنما تأتيه الشريعة بتأكيد ما عنده، والتنبيه
عليه، فتثير ما هو كامن فيه، وموجود في فطرته، قد أخذه الله - تعالى -
وسطره فيه من مبدأ الخلق، فكل من له غريزة من العقل، ونصيب من الإنسانية
ففيه حركة إلى الفضائل، وشوق إلى المحاسن لا لشيء آخر أكثر من الفضائل
والمحاسن التي يقتضيها العقل، وتوجبها الإنسانية، وإن اقترن بذلك في بعض
الأوقات محبة الشكر، وطلب السمعة، والتماس أمور أخر.
ولولا أن محبة الشكر وما يتبعه - أيضاً - جميل وفضيلة لما رغب فيه، ولولا
أن الخالق - تعالى - واحد لما تساوت هذه الحال بالناس، ولا استجاب أحد لمن
دعا إليها، وحض عليها إذا لم يجد في نفسه شاهداً لها، ومصدقاً بها.
ولعمري إذا هذا أوضح دليل على توحيد الله، تعالى ذكره، وتقدس اسمه.
مسألة ما الذي قام في نفس بعض الناس حتى صار ضحكة
؟أعني يضحك ويسخر منه ويعبث بقفاه، وهو في ذاك صابر محتسب، وربما خلا من النائل، وربما نزر النائل.
فكيف هون عليه الأمر القبيح؟ ولعله من بيت ظاهر الشرف، منيف المحل.
وبمثل هذا المعنى يصير آخر مخنثاً مغنياً لعاباً إلى آخر ما اقتصه من حديث الرجل الذي نشأ على طريق مذمومة، وهو من بيت كبير.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: مر لنا في مسألة الفراسة أن لكل مزاج خلقاً يتبعه، والنفس تصدر أفعالها بحسب تلك الطبيعة والمزاج، وأن الإنسان متى استرسل للطبيعة، وانقاد لهواه، ولم يستعمل القوة الموهوبة له في رفع ذلك، وتأديبه نفسه بها - كان في مسلاخ بهيمة!!!.
وهذا الخلق الذي ذكرته في هذه المسألة أحد الأخلاق التابعة لمزاج خارج عن الاعتدال التي من ترك الإنسان وسوم الطبيعة فيها جمحت فيه إلى أقبح مذهب وأسوأ طريقة.
وحق على من بلى بها أن يجتهد في مداواتها، ويجتهد له فيها.
فقد تقدم قولنا في هذا الباب إنه ممكن، ولولا إمكانه لما حسن التقويم والتأديب عليه، ولا الحمد والذم فيه، ولا الزجر والدعاء إليه، ولا السياسة من الآباء والملوك، وقوام المدن به.
ومتى لم يستجب إنسان لمعالجة هذه الأدواء كانت معالجته بالعقوبات المفروضة واجبة فيه.
وما أشبه الأمراض النفسانية بالأمراض الجسمانية، فكما أن مرض الجسم متى لم يعالجه صاحبه بالاختيار والإيثار، وجب أن يعالج بالقهر والقسر، فكذلك مرض النفس إلى أن ينتهي إلى حال يقع معها اليأس من الصلاح، فحينئذ ينبغي أن يراح من نفسه، ويستراح منه، وتطهر الأرض منه على حسب ما تحكم فيه الشريعة أو السياسة الفاضلة.
مسألة ما السبب في محبة الإنسان الرئاسة
؟ومن أين ورث هذا الخلق
؟وأي شيء رمزت الطبيعة به؟ ولم أفرط بعضهم في طلبها، حتى تلقى الأسنة بنحره، وواجه المرهفات بصدره، وحتى هجر من أجلها الوساد، وودع بسببها الرقاد، وطوى المهامه والبلاد؟ وهل هذا الجنس من جنس من امتعض في ترتيب العنوان إذا كوتب أوكاتب؟ وما ذاك من جميع ما تقدم؟ فقد تشاح الناس في هذه المواضع وتباينوا وبلغوا المبالغ.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد تبين أن في الناس ثلاث قوى، وهي: الناطقة، والبهيمية، والغضبية.
فهو بالناطقة منها يتحرك نحو الشهوات التي يتناول بها اللذات البدنية كلها.
ويظهر أثرها من الكبد.
وبالغضبية منها يتحرك إلى طلب الرئاسات، ويشتاق إلى أنواع الكرامات، وتعرض له الحمية والأنفة، ويلتمس العز والمراتب الجليلة العالية، ويظهر أثرها من القلب.
وإنما تقوى فيه واحدة من هذه القوى بحسب مزاج قوة هذه الأعضاء التي تسمى الرئيسية في البدن.
فربما خرج عن الاعتدال فيها إلى جانب الزيادة والإفراط، أو إلى
ناحية النقصان والتفريط، فيجب عليه حينئذ أن يعد لها ويردها إلى الوسط -
أعني الاعتدال الموضوع له - ولا يسترسل لها بترك التقويم والتأديب؛ فإن
هذه القوى تهيج لما ذكرناه.
فإن تركت وسومها، وترك صاحبها إصلاحها وعلاجها بالأعقال واتباع الطبيعة -
تفاقم أمرها، وغلبت حتى تجمح إلى حيث لا يطمع في علاجها ويؤيس من برئها.
وإنما يملك أمرها وتأديبها في مبدأ الأمر بالنفس التي هي رئيسة عليها كلها
- أعني المميزة العاقلة، التي تسمى القوة الإلهية - فإن هذه القوة ينبغي
أن تستولي، وتكون لها الرئاسة على الباقية.
فمحبة الإنسان للرئاسة أمر طبيعي له، ولكن يجب أن تكون مقومة؛ لتكون في
موضعها، وكما ينبغي.
فإن زادت أو نقصت في إنسان لأجل مزاج أو عادة سيئة وجب عليه أن يعد لها
بالتأديب؛ ليتحرك كما ينبغي، وعلى ما ينبغي، وفي الوقت الذي ينبغي.
وقد مضى من ذكر هذه القوى وآثارها في موضعه ما يجب أن يقتصر بها هنا على
هذا المقدار.
ونقول: إنه كما يعرض لبعض الناس ان يلقى الأسنة بنحره، ويركب أهوال البر
والبحر لنيل الشهوات بحسب حركة قوة النفس البهيمية فيه، وتركه قمعها -
فكذلك يعرض لبعضهم في نهوض قوة النفس الغضبية فيهم إلى نيل الرئاسات
والكرامات - أن يركب هذه الأهوال فيها.
ومدار الأمر على العقل الذي هو الرئيس عليها، وأن يجتهد الإنسان في تقوية
هذه النفس؛ لتكون هي الغالبة، وتتعبد القواتان الباقيتان لها حتى تصدر عن
أمره وتتحرك لما ترسمه، وتقف عندما يحده؛ فإن هذه القوة هي التي تسمى
الإلهية، ولها قوة على رئاسة تلك الأخر، وهداية إلى علاجها وإصلاحها،
واستقلال بالرئاسة التامة عليها، ولكنها - كما قال أفلاطون - في لين الذهب
وتلك في قوة الحديد وللإنسان الاجتهاد والميل إلى تذليل هذه لتلك، فإنها
ستذل وتنقاد.
والله المعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
مسألة ما السبب في تشريف من سلف له
أي أو جد منظور إليه، مكثور عليه في فعال ممجد، وشجاعة وسياسة، دون تشريف من كان له ابن كذلك؟ أعني كيف يسري الشرف من المتقدم في المتأخر، ولا يسري من المتأخر في المتقدم؟.الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: إن الأب علة الولد، وعرفه يسري فيه؛ لأنه معلوله، ولأنه مكون من مزاجه وبزره، فهو من أجل ذلك كجزء منه، أو كنسخة له، فغير مستنكر أن يظهر أثر العلة فيه، أو ينتظر منه نزوع العرق إليه.
فأما عكس هذه القضية، وهو أن يصير المعلول سبباً للعلة حتى يرجع مقلوباً فشيء يأباه العقل، وترده البديهة، ويسير التأمل يكفي في جواب هذه المسألة.
مسألة ولم إذا كان أبو الإنسان مذكوراً بما أسلفنا نعته
وبغيره من الدين والورع - وجب أن يكون ولده، وولد ولده يسحبون الذيل، ويختالون في العطاف، ويزدرون الناس، ويرون من أنفسهم أنهم قد خولوا الملك، ويعتقدون أن خدمتك لهم فريضة، ونجاتك بهم متعلقة؟ ما هذه الفتنة والآفة؟ وما أصلها؟ وهل كان في سالف الدهر، وفيما مضى من الزمان من الأمم المعروفة هذا الفن؟.
الجواب: قال أبو علي مسكويه - رحمه الله: قد ذكرنا في جواب المسألة الأولى ما ينبه على جواب هذه التالية؛ فإن المعلول إنما يشرف بشرف علته، فإن كان ذلك الشرف ديناً وعلته الهيئة حصل للعرق الساري من الافتخار به ما لا يحصل لغيره، ولكن إلى حد مفروض، ومقدار معلوم، فأما الغلو فيه إلى أن يعتقد أنهم كما حكيت عنهم فهو كسائر الإفراطات التي عددناها فيما تقدم.
وأما قولك: هل كان في سالف الدهر شيء من هذا الفن؟ فلعمري لقد كان ذلك في كل أمة، وكل زمان.
ولم تزل النجابة على الأكثر سارية في الأولاد، ومتوقعة في العروق حتى إن الملك يبقى في البيت الواحد زماناً طويلاً لا يرتضى الناس إلا بهم، ولا ينقادون إلا لهم.
وذلك في جميع الأمم من الفرس والروم والهند وسائر أجناس الناس.
وكذلك العرق اللئيم، والأصل الفاسد يهجي به الأولاد، وينتظر منهم إليه فيذمون به، وتتجنب ناحيتهم له.