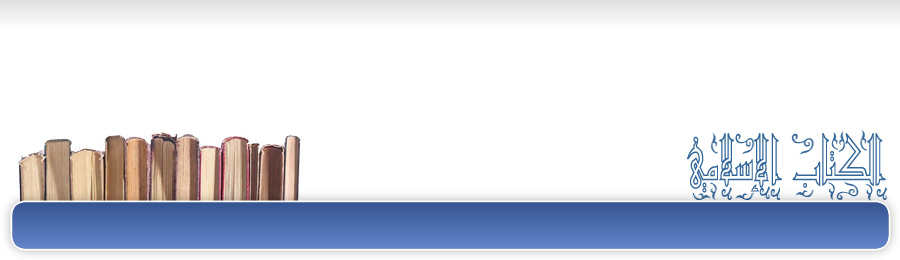كتاب : القواعد النوارنية الفقهية
المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس
كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن لم يفعل فليمسك أرضه
أخرجاه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه
وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله
عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها
أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها وفي رواية الصحيح ولا يكريها وفي رواية
في الصحيح نهى عن كراء الأرض
وقد ثبت أيضا في الصحيحين عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وفي رواية في الصحيحين عن زيد ابن
أبي أنيسة عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشترى النخل حتى يشقه والإشقاه أن يحمر
أو يصفر أو يؤكل منه شئ والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم
والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه
ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال نعم
فهذه الأحاديث قد يستدل بها من ينهى عن المؤاجرة والمزارعة لأنه نهى عن
كرائها والكراء يعمها لأنه قال فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن لم يفعل
فليمسكها فلم يرخص إلا في أن يزرعها أو يمنحها لغيره ولم يرخص في المعارضة
عنه لا بمؤاجرة ولا بمزارعة
ومن يرخص في المزارعة دون المؤاجرة يقول الكراء هو الإجارة أو المزارعة
الفاسدة التي كانوا يفعلونها بخلاف المزارعة الصحيحة التي ستأتي أدلتها
والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بها أهل خيبر وعمل بها الخلفاء
الراشدون وسائر الصحابة من بعده يؤيد ذلك أن ابن عمر الذي ترك كراء الأرض
لما حدثه رافع كان يروي
حديث أهل خيبر رواية من يفتي به وأن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وجميع ذلك من أنواع الغرر
والمؤاجرة أظهر في الغرر من المزارعة كما تقدم
ومن يجوز المؤاجرة دون المزارعة يستدل بما رواه مسلم في صحيحه عن ثابت ابن
الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة
وقال لا بأس بها فهذا صريح في النهى عن المزارعة والأمر بالمؤاجرة ولأنه
سيأتي عن رافع بن خديج الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن كرائها بشيء معلوم مضمون وإنما
نهاهم عما كانوا يفعلونه من المزارعة
وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم كأحمد بن حنبل وأصحابه كله من
المتقدمين والمتأخرين وإسحاق بن راهويه وأبي بكر بن أبي شيبة وسليمان بن
دواد الهاشمي وأبي خيثمة زهير بن حرب وأكثر فقهاء الكوفيين كسفيان الثوري
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة
والبخاري صاحب الصحيح وأبي داود وجماهير فقهاء الحديث من المتأخرين كابن
المنذر وابن خزيمة والخطابي وغيرهم وأهل الظاهر وأكثر أصحاب أبي حنيفة إلى
جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور المسلمين وبينوا
معاني الأحاديث التي يظن اختلافها في هذا الباب
فمن ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر وهو وخلفاؤه من بعده
إلى أن أجلاهم عمر فعن ابن عمر قال عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع أخرجاه وأخرجا أيضا عن ابن عمر أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهل خيبر على أن يعملوها ويزرعوها ولهم
شطر ما خرج منها هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم لما
افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم
فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا وكان الثمر على السهمان من
نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس وفي رواية مسلم عن عبد
الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل
خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وللرسول صلى الله عليه وسلم شطر
ثمرها وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على
النصف نخلها وأرضها رواه الإمام أحمد وابن ماجة وعن طاوس أن معاذ بن جبل
أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان
على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا رواه ابن ماجة وطاوس كان
بالمين وأخذ عن أصحاب معاذ الذين باليمن من أعيان المخضرمين وقوله وعمر
وعثمان أي كنا نفعل كذلك على عهد عمر وعثمان فحذف الفعل لدلالة الحال عليه
لأن المخاطبين كانوا يعلمون أن معاذا خرج من اليمن في خلافة الصديق وقدم
الشام في خلافة عمر ومات بها في خلافته قال البخاري في صحيحه وقال قيس ابن
مسلم عن أبي جعفر يعني الباقر ما بالمدينة دار هجرة إلا يزرعون على الثلث
والربع قال وزارع علي وسعد ابن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد
العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين وعامل عمر
الناس على انه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم
كذا وهذه الآثار التي ذكرها البخاري قد رواها غير واحد من المصنفين في
الآثار
فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزرعون والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة
والتابعين من غير أن ينكر ذلك منكر لم يكن إجماع أعظم من هذا بل إن كان في
الدنيا إجماع فهو هذا لا سيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده إلى أن أجلا عمر
اليهود إلى تيماء
وقد تأول من أبطل المزارعة و المساقاة ذلك بتأويلات مردودة مثل أن قال كان
اليهود عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم و المسلمين فجعلوا ذلك مثل
المخارجة بين العبد و سيده
و معلوم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم و لم يسترقهم
حتى أجلاهم عمر و لم يبعهم ولا مكن أحدا من المسلمين من استرقاق أحد منهم
ومثل أن قال هذه معاملة مع الكفار فلا يلزم أن تجوز مع المسلمين وهذا
مردود فإن خيبر كانت قد صارت دار إسلام وقد أجمع المسلمون أنه يحرم في دار
الإسلام بين المسلمين و أهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات
الفاسدة ثم إنا قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بين المهاجرين
و الأنصار و أن معاذ بن جبل عامل على عهده أهل اليمن بعد إسلامهم على ذلك
و أن الصحابة كانوا يعاملون بذلك و القياس الصحيح يقتضي جواز ذلك مع
عمومات الكتاب و السنة المبيحة أو النافية للحرج ومع الاستصحاب و ذلك من
وجوه
أحدها أن هذه المعاملة مشاركة ليست مثل المؤاجرة المطلقة فإن النماء
الحادث يحصل من منفعة أصلين منفعة العين التي لهذا كبدنه وبقره و منفعة
العين التي لهذا كأرضه و شجره كما تحصل المغانم بمنفعة أبدان الغانمين و
خيلهم و كما يحصل مال الفيء بمنفعة أبدان المسلمين من قوتهم و نصرهم بخلاف
الإجارة فإن المقصود فيها هو العمل أو المنفعة فمن استأجر لبناء أو خياطة
أو شق الأرض أو بذرها أو حصاد فإذا وافاه ذلك العمل فقد استوفى المستأجر
مقصوده بالعقد و استحق الأجير أجره و لذلك يشترط في الإجارة اللازمة أن
يكون العمل مضبوطا كما يشترط مثل ذلك في المبيع وهنا منفعة بدن العامل و
بدن بقره وحديده هو مثل منفعة أرض المالك و شجره ليس مقصود واحد منهما
استيفاء منفعة الآخر و إنما مقصودهما جميعا ما يتولد من اجتماع
المنفعتين فإن حصل نماء اشتركا فيه و إن لم يحصل نماء ذهب على كل منهما
منفعته فيشتركان في المغنم و في المغرم كسائر المشتركين فيما يحدث من نماء
الأصول التي لهم وهذا جنس من التصرفات يخالف في حقيقته و مقصوده و حكمه
الإجارة المحضة وما فيه من شوب المعاوضة من جنس ما في الشركة من شوب
المعاوضة
فإن التصرفات العدلية في الأرض جنسان معاوضات و مشاركات فالمعاوضات كالبيع
و الإجارة و المشاركات شركة الأملاك و شركة العقد و يدخل في ذلك اشتراك
المسلمين في مال بيت المال و اشتراك الناس في المباحات كمنافع المساجد و
الأسواق المباحة و الطرقات وما يحيا من الموات أو يوجد من المباحات و
اشتراك الورثة في الميراث و اشتراك الموصى لهم و الموقوف عليهم في الوصية
و الوقف و اشتراك التجار و الصناع شركة عنان أو أبدان ونحو ذلك وهذان
الجنسان هما منشأ الظلم كما قال تعالى عن داود عليه السلام 38 24 { وإن
كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وقليل ما هم }
و التصرفات الأخرى هي الفضلية كالقرض و العارية و الهبة و الوصية وإذا
كانت التصرفات المبنية على المعادلة هي معاوضة أو مشاركة فمعلوم قطعا أن
المساقاة و المزارعة و نحوهما من جنس المشاركة ليسا من جنس المعاوضة
المحضة و الغرر إنما حرم بيعه في المعاوضة لأنه أكل مال الباطل وهنا لا
يأكل أحدهما مال الآخر لأنه لم ينبت الزرع فإن رب الأرض يأخذ منفعة الآخر
إذ هو لم يستوفها ولا ملكها بالعقد ولا هي مقصوده بل ذهبت منفعة بدنه كما
ذهبت منفعة أرض هذا ورب الأرض لم يحصل له شيء حتى يكون قد أخذه و الآخر لم
يأخذ شيئا وبخلاف بيوع الغرر وإجارة الغرر فإن أحد المتعاوضين بأخذ شيئا
والآخر يبقى تحت الخطر فيفضي إلى ندم أحدهما و خصومتهما
وهذا المعنى نتف في هذه المشاركات التي مبناها على المعادلة
المحضة التي ليس فيها ظلم البتة لا في غرر ولا في غير غرر
ومن تأمل هذا تبين له مأخذه هذه الأصول وعلم أن جواز هذه أشبه بأصول
الشريعة و أعرف في العقول و أبعد عن كل محذور من جواز إجارة الأرض بل ومن
جواز كثير من البيوع و الإجارات المجمع عليها حيث هي مصلحة محضة للخلق بلا
فساد و إنما وقع اللبس فيها على من حرمها من إخواننا الفقهاء بعد ما فهموه
من الآثار من جهة أنهم اعتقدوا هذا إجارة على عمل مجهول لما فيها من عمل
بعوض و ليس كل من عمل لينتفع بعمله يكون أجيرا كعمل الشريكين في المال
المشترك و عمل الشريكين في شركة الأبدان و كاشتراك الغانمين في المغانم و
نحو ذلك مما لا يعد ولا يحصى نعم لو كان أحدهما يعمل بمال يضمنه له الآخر
لا يتولد من عمله كان هذا إجارة
الوجه الثاني أن هذه من جنس المضاربة فإنها عين تنمو بالعمل عليها فجاز
العمل عليها ببعض نمائها كالدراهم و الدنانير و المضاربة جوزها الفقهاء
الفقهاء كلهم اتباعا لما جاء فيها عن الصحابة رضي الله عنهم مع أنه لا
يحفظ فيها بعينها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد كان أحمد يرى أن
يقيس المضاربة على المساقاة و المزارعة لأنها تبتت بالنص فتجعل أصلا يقاس
عليه و إن خالف فيها من خالف و قياس كل منهما على الآخر صحيح فإن من ثبت
عنده جواز أحدهما أمكنه أن يستعمل فيه حكم الآخر لتساويها
فإن قيل الربح في المضاربة ليس من عين الأصل بل الأصل يذهب و يجيء بدله
فالمال المقسم حصل بنفس العمل بخلاف الثمر و الزرع فإنه من نفس الأصل
قيل هذا الفرق فرق في الصورة وليس له تأثير شرعي فإنا نعلم بالاضطرار أن
المال المستفاد إنما حصل بمجموع منفعة بدن العامل و منفعة رأس المال ولهذا
يرد إلى رب المال مثل رأس ماله و يقتسمان الربح كما أن العامل
يبقى بنفسه التي هي نظير الدراهم و ليست إضافة الربح إلى عمل بدن هذا
بأولى من إضافته إلى منفعة مال هذا
ولهذا فالمضاربة التي تروونها عن عمر إنما حصلت بغير عقد لما أقرض أبو
موسى الأشعري لابني عمر من مال بيت المال فتحملاه إلى أبيهما فطلب عمر
جميع الربح لأنه رأى ذلك كالغصب حيث أقرضهما ولم يقرض غيرهما من المسلمين
و المال مشترك و أحد الشركاء إذا اتجر في المال المشترك بدون إذن الآخر
فهو كالغاصب في نصيب الشريك و قال له ابنه عبد الله الضمان كان علينا
فيكون الربح لنا فأشار عليه بعض الصحابة بأن يجعله مضاربة
وهذه الأقوال الثلاثة في مثل هذه المسألة موجودة بين الفقهاء وهي ثلاثة
أقوال في مذهب أحمد وغيره هل يكون ربح من اتجر بمال غيره بغير إذنه لرب
المال أو للعامل أولهما على ثلاثة أقوال و أحسنها و أقيسها أن يكون مشتركا
بينهما كما قضى به عمر لأن النماء متولد عن الأصلين
و إذا كان أصل المضاربة الذي اعتمدوا قد عليه راعوا فيه ما ذكرناه من
الشركة فأخذ مثل الدراهم يجري مجرى عينها ولهذا سمى النبي صلى الله عليه
وسلم و المسلمون بعده القرض منيحة يقال منيحة ورق ويقول الناس أعرني
دراهمك يجعلون رد مثل الدراهم مثل رد عين العارية و المقترض انتفع بها
وردها و سموا المضاربة قراضا لأنها في المقابلات نظير القرض في التبرعات
ويقال أيضا لو كان ما ذكروه من الفرق مؤثرا لكان اقتضاءه لتجويز المزارعة
دون المضاربة أولى من العكس لأن النماء إذ حصل مع بقاء الأصلين كان أولى
بالصحة من حصوله مع ذهاب أحدهما و إن قيل الزرع نماء الأرض دون البدن فقد
يقال و الربح نماء العامل دون الدراهم أو بالعكس وكل هذا
باطل بل الزرع يحصل بمنفعة الأرض المشتملة على التراب و الماء و
الهواء و منفعة بدن العامل و البقر والحديد
ثم لو سلم أن بينها وبين المضاربة فرقا فلا ريب أنها بالمضاربة أشبه منها
بالمؤاجرة لأن المؤاجرة المقصود فيها هو العمل و يشترط أن يكون معلوما و
الأجرة مضمونة في الذمة أو عين معينة وهنا ليس المقصود إلا النماء ولا
يشترط معرفة العمل و الأجرة ليست عينا ولا شيئا في الذمة و إنما هي بعض ما
يحصل من النماء و لهذا متى عين فيها شيء معين فسد العقد كما تفسد المضاربة
إذا شرطا لأحدهما ربحا معينا أو أجرة معلومة في الذمة وهذا بين في الغاية
فإذا كانت بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة جدا والفرق الذي بينها وبين
المضاربة ضعيف والذي بينهما وبين المؤاجرة فروق غير مؤثرة في الشرع و
العقل و كان لا بد من إلحاقها بأحد الأصلين و إلحاقها بما هي به أشبه أولى
وهذا أجلى من أن يحتاج فيه إلى إطناب
الوجه الثالث أن نقول لفظ الإجارة فيه عموم و خصوص فإنها على ثلاث مراتب
أحدها أن يقال لكل من بذل نفعا بعوض فيدخل في ذلك المهر كما في قوله تعالى
{ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } وسواء كان العمل هنا معلوما أو
مجهولا وكان الآخر معلوما أو مجهولا لازما أو غير لازم
المرتبة الثانية الإجارة التي هي جعالة وهو أن يكون النفع غير معلوم لكن
العوض مضمونا فيكون عقدا جائزا غير لازم مثل أن يقول من رد علي عبدي فله
كذا فقد يرده من كان بعيدا أو قريبا
الثالثة الإجارة الخاصة وهي أن يستأجر عينا أو يستأجره على عمل في الذمة
بحيث تكون المنفعة معلومة فيكون الأجر معلوما و الإجارة لازمة وهذه
الإجارة التي تشبه البيع في عامة أحكامه و الفقهاء المتأخرون إذا
أطلقوا الإجارة أو قالوا باب الإجارة أرادوا هذا بالمعنى
فيقال المساقاة و المزارعة و المضاربة و نحوهن من المشاركات على نماء يحصل
من قال هي إجارة بالمعنى الأعم أو العام فقد صدق ومن قال هي إجارة بالمعنى
الخاص فقد أخطأ و إذا كانت إجارة بالمعنى العام التي هي الجعالة فهنالك إن
كان العوض شيئا مضمونا من عين أو دين فلا بد أن يكون معلوما وأما إن كان
العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءا شائعا فيه كما لو قال الأمير في
الغزو من دلنا على حصن كذا فله منه كذا فحصول الجعل هناك مشروط بحصول
المال مع أنه جعالة محضة لا شركة فيه فالشركة أولى و أحرى ويسلك في هذا
طريقة أخرى فيقال الذي دل عليه قياس الأصول أن الإجارة الخاصة يشترط فيها
أن يكون العوض غررا قياسا على الثمن فأما الإجارة العامة التي لا يشترط
فيها العلم بالمنفعة فلا تشبه هذه الإجارة لما تقدم فلا يجوز إلحاقها بها
فتبقى على الأصل المبيح
فتحرير المسألة أن المعتقد لكونها إجارة يستفسر عن مراده بالإجارة فإن
أراد الخاصة لم يصح و إن أراد العامة فأين الدليل على تحريمها إلا بعوض
معلوم فإن ذكر قياسا بين له الفرق الذي لا يخفى على غير فقيه فضلا عن
الفقيه ولن تجد إلى أمر يشمل مثل هذه الإجارة سبيلا فإذا انتفت أدلة
التحريم ثبت الحال
و يسلك في هذا طريقة أخرى وهو قياس العكس وهو أن يثبت في الفرع نقيض حكم
الأصل لانتفاء العلة المقتضية لحكم الأصل فيقال المعنى الموجب لكون الأجرة
يجب أن تكون معلومة منتف في باب المزارعة و نحوها لأن المقتضي لذلك أن
المجهول غرر فيكون في معنى بيع الغرر المقتضي أكل
المال بالباطل أو ما يذكر من هذا الجنس وهذه المعاني منتفية في
الفرع فإذا لم يكن التحريم موجب إلا كذا وهو منتف فلا تحريم
و أما الأحاديث حديث رافع بن خديج و غيره فقد جاءت مفسرة مبينة لنهي النبي
صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن نهيا عما فعل هو و الصحابة في عهده و بعده
بل الذي رخص فيه غير الذي نهى عنه فعن رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل
المدينة مزدرعا كنا نكرى الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض قال مما
يصاب ذلك و تسلم الأرض ومما تصاب الأرض و يسلم ذلك فنهينا فأما الذهب و
الورق فلم يكن يومئذ رواه البخاري وفي رواية له قال كنا أكثر أهل المدينة
حقلا وكان أحدنا يكرى أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه
ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية فربما أخرجت هذه
كذا ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق وفي صحيح مسلم عن رافع
قال كنا أكثر أهل الأمصار حقلا قال كنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم
هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك و أما الورق فلم ينهنا
وفي مسلم أيضا عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض
بالذهب و الورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات و أقبال الجداول و أشياء من الزرع
فيهلك هذا ويسلم هذا و يهلك هذا و يسلم هذا فلم يكن الناس كراء إلا هذا
فلذلك زجر الناس عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به
فهذا رافع بن خديج الذي عليه مدار الحديث يذكر أنه لم يكن لهم على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء إلا بزرع مكان معين من الحقل و هذا
النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء قاطبة و حرموا نظيره في المضاربة فلو
اشترط ربح ثوب بعينه لم يجز وهذا الغرر في المشاركات نظير الغرر في
المعاوضات
و ذلك أن الأصل في هذه المعاوضات و المقابلات هو التعادل من الجانبين فإن
اشتمل أحدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم فحرمها الله الذي حرم الظلم على
نفسه و جعله محرما على عباده فإن كان أحد المتبايعين إذا ملك الثمن و بقي
الآخر تحت الخطر لم يجز و لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمر
قبل بدو صلاحه فكذلك هذا إذا اشترطا لأحد الشريكين مكانا معينا خرجا عن
موجب الشركة فإن الشركة تقتضي الاشتراك في النماء فإذا انفرد أحدهما
بالمعين لم يبق للآخر فيه نصيب و دخله الخطر و معنى القمار كما ذكره رافع
في قوله فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فيفوز أحدهما و يخيب الآخر وهذا
معنى القمار و أخبر رافع أنه لم يكن لهم كراء على عهد النبي صلى الله عليه
وسلم إلا هذا و أنه إنما زجر عنه لأجل ما فيه من المخاطرة و معنى القمار و
أن النهي إنما انصرف إلى ذلك الكراء المعهود لا إلى ما يكون فيه الأجرة
مضمونة في الذمة وسأشير إن شاء الله إلى مثل ذلك في نهيه عن بيع الثمار
حتى يبدو صلاحها و رافع أعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء وقع
وهذا والله أعلم هو الذي انتهى عنه عبد الله بن عمر فإنه قال لما حدثه
رافع قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على الأربعاء و بشيء من التبن فبين
أنهم كانوا يكرون بزرع مكان معين و كان ابن عمر يفعله لأنهم كانوا يفعلونه
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغه النهي
يدل على ذلك أن ابن عمر كان يروي حديث معاملة خيبر دائما و يفتي به و يفتي
بالمزارعة على الأرض البيضاء و أهل بيته أيضا بعد حديث رافع فروى حرب
الكرماني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه حدثنا معتمر بن سليمان
سمعت كليب بن وائل قال أتيت ابن عمر فقلت أتاني رجل له أرض و ماء وليس له
بذر ولا بقر فأخذتها بالنصف فبذرت فيها بذري و عملت فيها ببقري فناصفته
قال حسن وقال حدثنا ابن أخي حزم حدثنا
يحيى بن سعيد حدثنا سعيد بن عبيد سمعت سالم بن عبد الله و أتاه رجل فقال الرجل منا ينطلق إلى الرجل فيقول أجيء ببذري و بقري و أعمل أرضك فما أخرج الله منه فلك منه كذا ولي منه كذا قال لا بأس به ونحن نصنعه و هكذا أخبر أقارب رافع ففي البخاري عن رافع قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينبت على الأربعاء أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقيل لرافع فكيف بالدينار و الدرهم فقال ليس بأس بالدينار و الدرهم وكان الذي نهى عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال و الحرام لم يجزه لما فيه من المخاطرة وعن أسيد بن ظهير قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع و النصف و يشترط ثلاث جداول و القصارة و ما سقى الربيع و كان العيش إذ ذاك شديدا و كان يعمل فيها بالحديد و ما شاء الله و يصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع رواه أحمد و ابن ماجة و روى أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم زاد أحمد و ينهاكم عن المزابنة و المزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول أخذته بكذا و كذا و سقا من تمر و القصارة ما سقط من السنبل و هكذا أخبر سعد بن أبي وقاص و جابر فأخبر سعد أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزرع و ما سعد بالماء مما حول البئر فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا ذلك و قال اكروا بالذهب و الفضة رواه أحمد و أبو داود و النسائي فهذا صريح في الإذن بالكراء بالذهب والفضة و أن النهي إنما كان عن اشتراط زرع مكان معين و عن جابر رضي الله عنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصيب
من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له
أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه أو فليدعها رواه مسلم
فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا عنه النهي قد أخبروا
بالصورة التي نهى عنها و العلة التي نهى من أجلها و إذا كان قد جاء في بعض
طرق الحديث أنه نهى عن كراء المزارع مطلقا فالتعريف للكراء المعهود بينهم
و إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكروا المزارع فإنما أراد
الكراء الذي يعرفونه كما فهموه من كلامه وهم أعلم بمقصوده و كما جاء مفسرا
عنه أنه رخص في غير ذلك الكراء و كما يشبه ذلك ما قرن به النهي من
المزابنة و نحوها و اللفظ و إن كان في نفسه مطلقا فإنه إذا كان خطابا
لمعين في مثل الجواب عن سؤال أو عقب حكاية حال ونحو ذلك فإنه كثيرا ما
يكون مقيدا بمثل حال المخاطب كما لو قال المريض للطبيب إن به حرارة فقال
له لا تأكل الدسم فإنه يعلم أن النهي مقيد بتلك الحال
و ذلك أن اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهود أو حال يقتضيه انصرف إليه و
إن كان نكرة كالمتبايعين إذا قال أحدهما بعتك بعشرة دراهم فإنها مطلقة في
اللفظ ثم لا ينصرف إلا إلى المعهود من الدراهم فإذا كان المخاطبون لا
يتعارفون بينهم لفظ الكراء إلا كذلك الذي كانوا يفعلونه ثم خوطبوا به لم
ينصرف إلا إلى ما يعرفونه وكان ذلك من باب التخصيص العرفي كلفظ الدابة إذا
كان معروفا بينهم أنه الفرس أو ذوات الحافر فقال لا تأتني بدابة لم ينصرف
هذا المطلق إلا إلى ذلك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان مقيدا
بالعرف و بالسؤال وقد تقدم ما في الصحيحين عن رافع بن خديج وعن ظهير بن
رافع قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ما تصنعون بمحاقلكم
قلت نؤاجرها بما على الربيع وعلى الأوسق من التمر
و الشعير قال لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها )
فقد صرح بأن النهي وقع عما كانوا يفعلونه وأما المزارعة المحضة فلم
يتناولها النهي ولا ذكرها رافع و غيره فيما يجوز من الكراء لأنها والله
أعلم عندهم جنس آخر غير الكراء المعتاد فإن الكراء اسم لما وجب فيه أجرة
معلومة إما عين و إما دين فإن كان دينا في الذمة مضمونا فهو جائز و كذلك
إن كان عينا من غير الزرع و أما إن كان عينا من الزرع لم يجز
فأما المزارعة بجزء شائع من جميع الزرع فليس هو الكراء المطلق بل هو شركة
محضة إذ ليس جعل العامل مكتريا للأرض بجزء من الزرع بأولى من جعل المالك
مكتريا للعامل بالجزء الآخر و إن كان من الناس من يسمي هذا كراء أيضا
فإنما هو كراء بالمعنى العام الذي تقدم بيانه فأما الكراء الخاص الذي تكلم
به رافع وغيره فلا و لهذا السبب بين رافع أحد نوعي الكراء الجائز و بين
النوع الآخر الذي نهوا عنه ولم يتعرض للشركة لأنها جنس آخر
بقي أن يقال فقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو
ليمنحها أخاه و إلا فليمسكها أمر إذا لم يفعل واحدا من الزرع و المنيحة أن
يمسكها و ذلك يقتضي المنع من المؤاجرة و من المزارعة كما تقدم
فيقال الأمر بهذا أمر ندب و استحباب لا أمر أيجاب أو كان أمر أيجاب في
الابتداء لينزجروا عما اعتادوه من الكراء الفاسد وهذا كما أنه صلى الله
عليه وسلم لما نهاهم عن لحوم الحمر الأهلية قال في الآنية التي كانوا
يطبخون فيها أهريقوا ما فيها و اكسروها وقال صلى الله عليه وسلم في آنية
أهل الكتاب حين سأله عنها أبو ثعلبة الخشني إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا
فيها و إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وذلك لأن النفوس إذا اعتادت
المعصية فقد لا تنفطم عنها انفطاما جيدا إلا بترك ما يقاربها من المباح
كما قيل لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه و بين الحرام حاجزا من
الحلال كما أنها أحيانا لا تترك المعصية إلا بتدريج لا بتركها
جملة
فهذا يقع تارة و هذا يقع تارة و لهذا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه
وسلم لمن خشي منه النفرة عن الطاعة الرخصة له في أشياء يستغني بها عن
المحرم و لمن وثق بإيمانه و صبره النهي عن بعض ما يستحب له تركه مبالغة في
فعل الأفضل ولهذا يستحب لمن وثق بإيمانه و صبره من فعل المستحبات البدنية
و المالية كالخروج عن جميع ماله مثل أبي بكر الصديق ما لا يستحب لمن لم
يكن حاله كذلك كالرجل الذي جاءه ببيضة من ذهب فحذفه بها فلو أصابته
لأوجعته ثم قال يذهب أحدكم فيخرج ماله ثم يجلس كلا على الناس
يدل على ذلك ما قدمناه من رواية مسلم الصحيحة عن ثابت بن الضحاك أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة و أمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها وما
ذكرناه من رواية سعد بن أبي وقاص أنه نهاهم أن يكروا بزرع موضع معين وقال
كروا بالذهب و الفضة و كذلك فهمته الصحابة فإن رافع ابن خديج قد روى ذلك
وأخبر أنه لا بأس بكرائها بالذهب و الفضة و كذلك فقهاء الصحابة كزيد بن
ثابت و ابن عباس ففي الصحيحين عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس لو تركت
المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال أي عمرو
إني أعطيهم و أعينهم و إن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله
عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه
خرجا معلوما وعن ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم
المزارعة و لكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض رواه مسلم مجملا و الترمذي وقال
حديث حسن صحيح فقد أخبر طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
وسلم إنما دعاهم إلى الأفضل وهو التبرع قال وأنا أعينهم و أعطيهم و أمر
النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق الذي منه واجب وهو ترك الربا و الغرر
ومنه مستحب كالعارية و القرض و لهذا لما كان التبرع بالأرض بلا أجرة من
باب الإحسان كان المسلم أحق به فقال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من
أن يأخذ عليه خرجا معلوما وقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه
أو ليمسكها فكان الأخ هو الممنوح ولما كان أهل الكتاب ليسوا من الإخوان
عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنحهم لا سيما و التبرع إنما يكون
عن فضل غني فمن كان محتاجا إلى منفعة أرضه لم يستحب له المنيحة كما كان
المسلمون محتاجين إلى منفعة أرض خيبر وكما كان الأنصار محتاجين في أول
الإسلام إلى أرضهم حيث عاملوا عليها المهاجرين وقد توجب الشريعة التبرع
عند الحاجة كما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي
لأجل الدافة التي دفت ليطعموا الجياع لأن إطعامهم واجب فلما كان المسلمون
محتاجين إلى منفعة الأرض و أصحابها أغنياء عنها نهاهم عن المعاوضة ليجودوا
بالتبرع ولم يأمرهم بالتبرع عينا كما نهاهم عن الادخار فإن من نهى عن
الانتفاع بماله جاد ببذله إذ لا يترك بطالا وقد ينهى النبي صلى الله عليه
وسلم بل الأئمة عن بعض أنواع المباح في بعض الأحوال لما في ذلك من منفعة
المنهي كما نهاهم في بعض المغازي و أما ما رواه جابر من نهيه صلى الله
عليه وسلم عن المخابرة فهذه هي المخابرة التي نهى عنها و اللام لتعريف
العهد ولم تكن المخابرة عندهم إلا ذلك
يبين ذلك ما في الصحيح عن ابن عمر قال كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام
أول فزعم رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه من أجله
فأخبر ابن عمر أن رافعا روى النهي عن الخبر وقد تقدم معنى حديث
رافع قال أبو عبيد الخير بكسر الخاء بمعنى المخابرة والمخابرة المزارعة
بالنصف والثلث والربع وأقل وأكثر وكان أبو عبيد يقول لهذا سمى الأكار
خيبرا لأنه يخابر على الأرض والمخابرة هي المؤاكرة
وقد قال بعضهم أصل هذا من خيبر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها في
أيديهم على النصف فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر وليس هذا بشيء فإن
معاملته بخيبر لم ينه عنها قط بل فعلها الصحابة في حياته وبعد موته وإنما
روى حديث المخابرة رافع بن خديج وجابر وقد فسرا ما كانوا يفعلونه والخبير
هو الفلاح سمى بذلك لأنه يخبر الأرض
وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى الفرق بين المخابرة والمزارعة فقالوا
المخابرة هي المعاملة على أن يكون البذر من العامل والمزارعة على أن يكون
البذر من المالك قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة لا
المزارعة
وهذا أيضا ضعيف فإنا قد ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في الصحيح
من أنه نهى عن المزارعة كما نهى عن المخابرة وكما نهى عن كراء الأرض وهذه
الألفاظ في أصل اللغة عامة لموضع نهيه وغير موضع نهيه وإنما اختصت بما
يفعلونه لأجل التخصيص العرفي لفظا وفعلا ولأجل القرينة اللفظية وهي لام
العهد وسؤال السائل وإلا فقد نقل أهل اللغة أن المخابرة هي المزارعة و
الاشتقاق يدل على ذلك
فصل
والذين جوزوا المزارعة منهم من اشترط أن يكون البذر من المالك وقالوا هذه في المزارعة فإما إن كان البذر من العامل لم يجز وهذا إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه وأصحاب مالك والشافعي حيث يجوزون المزارعة وحجة هؤلاء قياسها على المضاربة وبذلك احتج أحمدأيضا قال الكرماني قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رجل
دفع أرضه إلى الأكار على الثلث و الربع قال لا بأس بذلك إذا كان البذر من
رب الأرض و البقر و الحديد و العمل من الأكار يذهب فيه مذهب المضاربة
ووجه ذلك أن البذر هو أصل الزرع كما أن المال هو أصل الربح فلا بد أن يكون
البذر ممن له الأصل ليكون من أحدهما العمل و من الآخر الأصل
و الرواية الثانية عنه لا يشترط ذلك بل يجوز أن يكون البذر من العامل وقد
نقل عنه جماهير أصحابه أكثر من عشرين نفسا أنه يجوز أن يكرى أرضه بالثلث و
الربع كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر
فقالت طائفة من أصحابه كالقاضي أبي يعلى إذا دفع أرضه لمن يعمل عليها
ببذره بجزء من الزرع للمالك فإن كان على وجه الإجارة جاز و إن كان على وجه
المزارعة لم يجز و جعلوا هذا التفريق تقريرا لنصوصه لأنهم رأوا في عامة
نصوصه صرائح كثيرة جدا في جواز كراء الأرض بجزء من الخارج منها و رأوا أن
هذا هو ظاهر مذهبه عندهم من أنه لا يجوز في المزارعة أن يكون البذر من
المالك كالمضاربة ففرقوا بين باب المزارعة و المضاربة وباب الإجارة
وقال آخرون منهم أبو الخطاب معنى قوله في رواية الجماعة يجوز كراء الأرض
ببعض الخارج منها أراد به المزارعة و العمل من الأكار قال أبو الخطاب و
متبعوه فعلى هذه الرواية إذا كان البذر من العامل فهو مستأجر للأرض ببعض
الخارج منها و إن كان من صاحب الأرض فهو مستأجر للعامل بما شرط له قال
فعلى هذا ما يأخذه صاحب البذر يستحقه ببذره وما يأخذه من الأجرة يأخذه
بالشرط
وما قاله هؤلاء من أن نصه على المكاري ببعض الخارج هو المزارعة على أن
يبذر الأكار هو الصحيح ولا يحتمل الفقه إلا هذا و أن يكون نصه على جواز
المؤاجرة المذكورة يقتضي جواز المزارعة بطريق الأولى وجواز هذه
المعاملة مطلقا هو الصواب الذي لا يتوجه غيره أثرا و نظرا وهو
ظاهر نصوص أحمد المتواترة عنه و اختيار طائفة من أصحابه
و القول الأول قول من اشترط أن يبذر رب الأرض وقول من فرق بين أن يكون
إجارة أو مزارعة هو في الضعف نظير من سوى بين الإجارة الخاصة و المزارعة
أو أضعف
أما بيان نص أحمد فهو أنه إنما جوز المؤاجرة ببعض الزرع استدلالا بقصة
معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر و معاملته لهم إنما كانت
مزارعة لم تكن بلفظ الإجارة فمن الممتنع أن أحمد لا يجوز ما فعله النبي
صلى الله عليه وسلم إلا بلفظ الإجارة و يمنع فعله باللفظ المشهور
و أيضا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شارط أهل خيبر على
أن يعملوها من أموالهم كما تقدم ولم يدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم
بذرا فإذا كانت المعاملة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا
يبذرون فيها من أموالهم فكيف يحتج بها أحمد على المزارعة ثم يقيس عليها
إذا كانت بلفظ الإجارة ثم يمنع الأصل الذي احتج به من المزارعة التي بذر
فيها العامل و النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لليهود نقركم فيها ما
أقركم الله لم يشترط مدة معلومة حتى يقال كانت إجارة لازمة لكن أحمد حيث
قال في إحدى الروايتين إنه يشترط كون البذر من المالك فإنما قاله متابعة
لمن أوجبه قياسا على المضاربة و إذا أفتى العالم بقول لحجة ولهما معارض
راجح لم يستحضر حينئذ ذلك المعارض الراجح ثم لما أفتى بجواز المؤاجرة بثلث
الزرع استدلالا بمزارعة خيبر فلا بد أن يكون في خيبر كان البذر عنده من
العامل و إلا لم يصح الاستدلال فإن فرضنا أن أحمد فرق بين المؤاجرة بجزء
من الخارج و بين المزارعة ببذر العامل كما فرق بينهما طائفة من أصحابه
فمستند هذا الفرق ليس مأخذا شرعيا فإن أحمد لا يرى اختلاف أحكام العقود
باختلاف العبارات
كما يراه طائفة من أصحابه الذين يجوزون هذه المعاملة بلفظ
الإجارة و يمنعونها بلفظ المزارعة و كذلك يجوزون بيع ما في الذمة بيعا
حالا بلفظ البيع و يمنعونه بلفظ السلم لأنه يصير سلما حالا و نصوص أحمد و
أصوله تأبى هذا كما قدمناه عنه في مسألة صيغ العقود فإن الاعتبار في جميع
التصرفات القولية بالمعاني لا بما يحمل على الألفاظ كما شهد به أجوبته في
الأيمان و النذور و الوصايا و غير ذلك من التصرفات و إن كان هو قد فرق
بينهما كما فرق طائفة من أصحابه فيكون هذا التفريق رواية عنه مرجوحة
كالرواية المانعة من الأمرين
و أما الدليل على جواز ذلك فالسنة و الإجماع و القياس
أما السنة فما تقدم من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على أن
يعتملوها من أموالهم ولم يدفع إليهم بذرا ولما عامل المهاجرون و الأنصار
على أن البذر من عندهم قال حرب الكرماني حدثنا محمد بن نصر حدثنا حسان بن
إبراهيم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن حكيم أن عمر بن
الخطاب أجلى أهل نجران و أهل فدك و أهل خيبر و استعمل يعلى بن منية فأعطى
العنب و النخل على أن لعمر الثلثين و لهم الثلث و أعطى البياض يعني بياض
الأرض على إن كان البذر و البقر و الحديد من عند عمر فلعمر الثلثان و لهم
الثلث وإن كان منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر فهذا عمر رضي الله عنه و يعلى
بن منية عامله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل في خلافته بتجويز
كلا الأمرين أن يكون البذر من رب الأرض وأن يكون من العامل وقال حرب حدثنا
أبو معن حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن الحارث بن حصيرة الأزدي عن صخر بن
الوليد عن عمرو بن صليع بن محارب قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال إن
فلانا أخذ أرضا فعمل فيها و فعل فدعاه فقال ما هذه الأرض التي أخذت فقال
أرض أخذتها أكرى أنهارها
و أعمرها و أزرعها فما أخرج الله من شيء فلي النصف وله النصف
فقال لا بأس بهذا فظاهره أن البذر من عنده ولم ينهه علي عن ذلك ويكفي
إطلاق سؤاله و إطلاق علي الجواب
و أما القياس فقد قدمنا أن هذه المعاملة نوع من الشركة ليست من الإجارة
الخاصة و إن جعلت إجارة فهي من الإجارة العامة التي تدخل فيها الجعالة و
السبق والرمي وعلى التقديرين فيجوز أن يكون البذر منهما و ذلك أن البذر في
المزارعة ليس من الأصول التي ترجع إلى ربها كالثمن في المضاربة بل البذر
يتلف كما تتلف المنافع و إنما ترجع الأرض أو بدن البقرة و العامل فلو كان
البذر مثل رأس المال لكان الواجب أن يرجع مثله إلى مخرجه ثم يقتسمان الفضل
و ليس الأمر كذلك بل يشتركان في جميع الزرع فظهر أن الأصول فيها من أحد
الجانبين هي الأرض بمائها و هوائها و بدن العامل و البقر و اكتراء الحرث و
البقر يذهب كما تذهب المنافع و كما تذهب أجزاء من الماء و الهواء والتراب
فيستحيل زرعا و الله سبحانه يخلق الزرع من نفس الحب التراب و الماء و
الهواء كما يخلق الحيوان من ماء الأبوين بل ما يستحيل في الزرع من أجزاء
الأرض أكثر مما يستحيل من الحب و الحب يستحيل فلا يبقى بل يفلقه الله و
يحيله كما يحيل أجزاء الماء و الهواء و كما يحيل المني و سائر مخلوقاته من
الحيوان و المعدن و النبات وقع ما وقع من رأي كثير من الفقهاء اعتقدوا أن
الحب و النوى في الزرع و الشجر هو الأصل و الباقي تبع حتى قضوا في مواضع
بأن يكون الزرع و الشجر لرب النوى و الحب مع قلة قيمته و لرب الأرض أجرة
أرضه
و النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بضد هذا حيث قال من زرع في أرض قوم
بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته فأخذ أحمد و غيره من
فقهاء الحديث بهذا الحديث و بعض من أخذ به يرى أنه خلاف القياس و
أنه من صور الاستحسان وهذا لما انعقد في نفسه من القياس المتقدم وهو أن
الزرع تبع للبذر و الشجر تبع للنوى وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح
الذي تدل عليه الفطرة فإن إلقاء الحب في الأرض بمنزلة إلقاء المني في
الرحم سواء ولهذا تبع الولد الآدمي أمه في الحرية و الرق دون أبيه ويكون
الجنين البهيم لمالك الأم دون مالك الفحل الذي نما عن عسبه و ذلك لأن
الأجزاء التي استمدها من الأم أضعاف الأجزاء التي استمدها من الأب و إنما
للأب حق الابتداء فقط ولا ريب أنه مخلوق منهما جميعا و كذلك الحب و النوى
فإن الأجزاء التي خلق منها الشجر و الزرع أكثرها من التراب و الماء و
الهواء وقد يؤثر ذلك في الأرض فيتضعف بالزرع فيها لكن لما كانت هذه
الأجزاء تستخلف دائما فإن الله سبحانه لا يزال يمد الأرض بالماء و الهواء
و بالتراب إما مستحيلا من غيره و إما بالموجود ولا يؤثر في الأرض نقص
الأجزاء الترابية شيئا إما للخلف بالاستحالة و أما للكثرة لهذا صار يظهر
أن أجزاء الأرض في معنى المنافع بخلاف الحب و النوى الملقى فيها فإنه عين
ذاهبة غير مستخلفة ولا يعوض عنها لكن هذا القدر لا يوجب أن يكون البذر هو
الأصل فقط فإن العامل هو و بقره لا بد له مدة العمل من قوت و علف يذهب
أيضا ورب الأرض لا يحتاج إلى مثل ذلك ولذلك اتفقوا على أن البذر لا يرجع
إلى ربه كما يرجع في القراض و لو جرى عندهم مجرى الأصول لرجع
فقد تبين أن هذه المعاملة اشتملت على ثلاثة أشياء أصول باقية وهي الأرض
بدن العامل و البقر و الحديد و منافع فانية و أجزاء فانية أيضا وهي البذر
و بعض أجزاء الأرض و بعض أجزاء العامل وبقره فهذه الأجزاء الفانية
كالمنافع الفانية سواء فتكون الخيرة إليهما فيمن يبذل هذه الأجزاء و
يشتركان على أي وجه شاءا ما لم يفض إلى ما نهى عن النبي صلى الله عليه
وسلم من
أنواع الغرر أو الربا و أكل المال بالباطل ولهذا جوز أحمد سائر أنواع المشاركات التي تشبه المساقاة والمزارعة مثل أن يدفع دابته أو سفينته أو غيرهما إلى من يعمل عليها والأجرة بينهما
فصل
وهذا الذي ذكرناه من الإشارة إلى حكمة بيع الغرر وما يشبه ذلك يجمع 8 اليسر في هذه الأبواب فإنك تجد كثيرا ممن تكلم في هذه الأمور إما أن يتمسك بما بلغه من ألفاظ يحسبها عامة أو مطلقة أو بضرب من القياس المعنوي أو الشبهى فرضى الله عن أحمد حيث يقول ينبغى للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس وقال أيضا أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس ثم هذا التمسك يفضى إلى مالا يمكن اتباعه ألبتةومن هذا الباب بيع الديون دين السلم وغيره وأنواع من الصلح والوكالة وغير ذلك ولولا أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبوابا لذكرنا أنواعا من هذا
فصل
القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها فيما يحل منها ويحرم وما يصح منها ويفسد ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداوالذى يمكن ضبطه فيها قولان أحدهما أن يقال الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظر إلا ماورد الشرع باجازته فهذا قول أهل الظاهر وكثير من أصول أبي حنيفة تنبنى على هذا وكثير من أصول الشافعي وطائفة من أصول أصحاب مالك وأحمد فإن أحمد قد يعلل أحيانا بطلان العقد بكونه لم يرد فيه أثر ولا قياس كما قاله في إحدى الروايتين في وقف الإنسان على نفسه وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد ويقولون ما خالف مقتضى العقد فهو باطل أما أهل الظاهر فلم يصححوا
لا عقد ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع وإذا لم يثبت
جوازه أبطلوه واستصحبوا الحكم الذى قبله وطردوا ذلك طردا جاريا لكن خرجوا
في كثير منه إلى أقوال ينكرها عليهم غيرهم
وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أنه يصحح في العقود شروطا يخالف مقتضاها في
المطلق وإنما يصحح الشرط في المعقود عليه إذا كان العقد مما يمكن فسخه
ولهذا أبطل أن يشترط في البيع خيار ولا يجوز عنده تأخير تسليم المبيع بحال
ولهذا منع بيع العين المؤجرة وإذا ابتاع شجرة عليها ثمر للبائع فله
مطالبته بإزالته وإنما جوز الإجارة المؤخرة لأن الإجارة عنده لا توجب
الملك إلا عند وجود المنفعة أو عتق العبد المبيع أو الانتفاع به أو أن
يشترط المشترى بقاء الثمر على الشجر وسائر الشروط التي يبطلها غيره ولم
يصحح في النكاح شرطا أصلا لأن النكاح عنده لا يقبل الفسخ ولهذا لا ينفسخ
عنده بعيب أو إعسار أو نحوهما ولا يبطل بالشروط الفاسدة مطلقا وإنما صحح
أبو حنيفة خيار الثلاثة الأيام للأثر وهو عنده موضع استحسان
والشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل لكنه يستثني
مواضع للدليل الخاص فلا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث ولا استثناء منفعة
المبيع و نحو ذلك مما فيه تأخير تسليم المبيع حتى منع الإجارة المؤخرة لأن
موجبها وهو القبض لا يلي العقد ولا يجوز أيضا ما فيه منع المشتري من
التصرف المطلق إلا العتق لما فيه من السنة و المعنى لكنه يجوز استثناء
المنفعة بالشرع كبيع العين المؤجرة على الصحيح في مذهبه و كبيع الشجر مع
استيفاء الثمرة مستحقة البقاء و نحو ذلك و يجوز في النكاح بعض الشروط دون
بعض ولا يجوز اشتراطها دارها أو بلدها ولا أن يتزوج عليها ولا يتسرى ويجوز
اشتراط حريتها و إسلامها و كذلك سائر الصفات المقصودة على الصحيح من مذهبه
كالجمال و نحوه وهو ممن يرى فسخ النكاح بالعيب و الإعسار و انفساخه
بالشروط التي
تنافيه كاشتراط الأجل و الطلاق و نكاح الشغار بخلاف فساد المهر و
نحوه
و طائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول لكنهم
يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي كالخيار أكثر من ثلاث و كاستثناء البائع
منفعة المبيع و اشتراط المرأة على زوجها أن لا ينقلها و لا يزاحمها بغيرها
ونحو ذلك من المصالح فيقولون كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل إلا إذا
كان فيه مصلحة المتعاقدين
وذلك أن نصوص أحمد تقتضي أنه جوز من الشروط في العقود أكثر مما جوزه
الشافعي فقد يوافقونه في الأصل و يستثنون للمعارض أكثر مما استثنى كما قد
يوافق هو أبا حنيفة في الأصل و يستثني أكثر مما يستثني للمعارض
وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر و يتوسعون في الشروط أكثر منهم
لقولهم بالقياس و المعاني و آثار الصحابة و لما يفهمونه من معاني النصوص
التي ينفردون بها عن أهل الظاهر و عمدة هؤلاء قصة بريرة المشهورة وهو ما
خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت
أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها
لهم و يكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها
فجاءت من عندهم و رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت
ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه
وسلم فقال خذيها و اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله و أثنى عليه ثم
قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط
ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط قضاء الله أحق و شرط الله
أوثق و إنما الولاء لمن أعتق وفي رواية للبخاري اشتريها فأعتقيها و
ليشترطوا ما شاءوا فاشترتها فأعتقتها و اشترط أهلها ولاءها
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق و إن اشترطوا
مائة شرط وفي لفظ شرط الله أحق و أوثق وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن
عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية لتعتقها فقال أهلها نبيعكها على
أن ولائها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك
ذلك فإنما الولاء لمن أعتق وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرادت
عائشة أن تشتري جارية فتعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( لا يمنعك ذلك فإنما الولاء
لمن أعتق )
ولهم من هذا الحديث حجتان
إحداهما قوله ( ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) فكل شرط
ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع فليس في كتاب الله بخلاف ما
كان في السنة أو في الإجماع فإنه في كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع
السنة و الإجماع
ومن قال بالقياس وهم الجمهور قالوا إذا دل على صحته القياس المدلول عليه
بالسنة أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله فهو في كتاب الله
و الحجة الثانية أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على
اشتراط الولاء لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد و ذلك لأن العقود
توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع بمنزلة
تغيير العبادات وهذا نكتة القاعدة وهي أن العقود مشروعة على وجه فاشتراط
ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع و لهذا كان أبو حنيفة و مالك و الشافعي في
أحد القولين لا يجوزون أن يشترط في العبادات شرطا يخالف مقتضاها فلا
يجوزون للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذر متابعة لعبد الله بن عمر حيث كان
ينكر الاشتراط في الحج و يقول أليس حسبكم سنة نبيكم وقد استدلوا
على هذا الأصل بقوله تعالى { اليوم أكملت لكم دينكم } وقوله {
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون }
قالوا فالشروط و العقود التي لم تشرع تعد لحدود الله و زيادة في الدين
و ما أبطله هؤلاء من الشروط التي دلت النصوص على جوازها بالعموم أو
بالخصوص قالوا ذلك منسوخ كما قاله بعضهم في شروط النبي صلى الله عليه وسلم
مع المشركين عام الحديبية أو قالوا هذا عام أو مطلق فيخص بالشرط الذي في
كتاب الله
و احتجوا أيضا بحديث يروى في حكاية عن أبي حنيفة و ابن أبي ليلى وشريك أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع و شرط وقد ذكره جماعة من المصنفين في
الفقه ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث وقد أنكره أحمد و غيره من العلماء
وذكروا أنه لا يعرف و أن الأحاديث الصحيحة تعارضه و أجمع الفقهاء
المعروفون من غير خلاف أعلمه عن غيرهم أن اشتراط صفة في المبيع و نحوه
كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو
ذلك شرط صحيح
القول الثاني أن الأصل في العقود و الشروط الجواز و الصحة ولا يحرم منها و
يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه و إبطاله نصا أو قياسا عند من يقول به و
أصول أحمد المنصوص عنه أكثرها يجري على هذا القول و مالك قريب منه لكن
أحمد أكثر تصحيحا للشروط فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه
وعامة ما يصححه أحمد من العقود و الشروط فيها يشتبه بدليل خاص من أثر أو
قياس لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعا من الصحة ولا يعارض ذلك بكونه شرطا
يخالف مقتضى العقد أولم يرد به نص وكان قد بلغه في العقود و الشروط من
الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم و الصحابة ما لا تجده عند
غيره من الأئمة فقال بذلك وبما في معناه قياسا عليه وما اعتمده
غيره في إبطال الشروط من نص فقد يضعفه أو يضعف دلالته و كذلك قد يضعف ما
اعتمدوه من قياس وقد يعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب و السنة التي
سنذكرها في تصحيح الشروط كمسألة الخيار أكثر من ثلاث مطلقا فمالك يجوزه
بقدر الحاجة و أحمد في إحدى الروايتين عنه يجوز شرط الخيار في النكاح أيضا
و يجوزه ابن حامد و غيره في الضمان و نحوه و يجوز أحمد استثناء بعض منفعة
الخارج من ملكه في جميع العقود و اشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الإطلاق
فإذا كان لها مقتضى عند الإطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط و النقص منه
بالشرط ما لم يتضمن مخالفة الشرع كما سأذكره إن شاء الله
فيجوز للبائع أن يستثني بعض منفعة المبيع كخدمة العبد و سكنى الدار و نحو
ذلك إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغير اتباعا لحديث
جابر لما باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله و استثنى ظهره إلى المدينة
و يجوز أيضا للمعتق أن يستثني خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو
غيرهما اتباعا لحديث سفينة لما أعتقته أم مسلمة و اشترطت عليه خدمة النبي
صلى الله عليه وسلم ما عاش
و يجوز على عامة أقواله أن يعتق أمته و يجعل عتقها صداقها كما في حديث
صفية و كما فعله أنس بن مالك وغيره وإن لم ترض المرأة كأنه أعتقها و
استثنى منفعة البضع لكنه استثناها بالنكاح إذ استثناؤها بلا نكاح غير جائز
بخلاف منفعة الخدمة
ويجوز أيضا للواقف إذا وقف شيئا أن يستثني منفعته و غلته جميعها لنفسه مدة
حياته كما روي عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك و روي فيه حديث مرسل عن النبي
صلى الله عليه وسلم وهل يجوز وقف الإنسان على نفسه فيه عنه روايتان
و يجوز أيضا على قياس قوله استثناء بعض المنفعة في العين
الموهوبة و الصداق و فدية الخلع و الصلح عن القصاص و نحو ذلك من أنواع
إخراج الملك سواء كان بإسقاط كالعتق أو بتمليك بعوض كالبيع أو بغير عوض
كالهبة
و يجوز أحمد أيضا في النكاح عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح لما
في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن أحق الشروط أن
توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ومن قال بهذا الحديث قال إنه يقتضي أن
الشروط في النكاح أوكد منها في البيع و الإجارة وهذا مخالف لقول من يصحح
الشروط في البيع دون النكاح فيجوز أحمد أن تستثني المرأة ما يملكه الزوج
بالإطلاق فتشترط أن لا تسافر معه و لا تنتقل من دارها و تزيد على ما يملكه
بالإطلاق فتشترط أن تكون مخلية به فلا يتزوج عليها ولا يتسرى
و يجوز على الرواية المنصوصة عنه المصححة عند طائفة من أصحابه أن يشترط كل
واحد من الزوجين في الآخر صفة مقصودة كاليسار و الجمال ونحو ذلك و يملك
الفسخ بفواته وهو من أشد الناس قولا بفسخ النكاح و انفساخه فيجوز فسخه
بالعيب كما لو تزوج عليها وقد شرطت عليه أن لا يتزوج عليها و بالتدليس كما
لو ظنها حرة فطهرت أمة و بالخلف بالصفة على الصحيح كما لو شرط الزوج أن له
مالا فظهر بخلاف ما ذكر و ينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده
كالتوقيت و اشتراط الطلاق وهل يبطل بفساد المهر كالخمر و الميتة و نحو ذلك
فيه عنه روايتان إحداهما نعم كنكاح الشغار وهو رواية عن مالك و الثانية لا
ينفسخ لأنه تابع وهو عقد مفرز كقول أبي حنيفة و الشافعي
وعلى أكثر نصوصه يجوز أن يشترط على المشتري فعلا أو تركا في المبيع مما هو
مقصود للبائع أو للمبيع نفسه وإن كان أكثر متأخري أصحابه لا يجوزون من ذلك
إلا العتق وقد يروى ذلك عنه لكن الأول أكثر في كلامه ففي
جامع الخلال عن أبي طالب سألت أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط أن
يتسرى بها تكون جارية نفيسه يحب أهلها أن يتسرى بها ولا تكون للخدمة قال
لا بأس به و قال مهنا سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية فقال
له إذا أردت بيعها فأنا أحق بها بالثمن الذي تأخذها به مني قال لا بأس به
ولكن لا يطؤها ولا يقربها وله فيها شرط لأن ابن مسعود قال لرجل لا تقربنها
ولأحد فيها شرط وقال حنبل حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق
عن الزهري عن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة أن ابن مسعود اشترى جارية من
امرأته و شرط لها إن باعها فهي لها بالثمن الذي اشتراها به فسأل ابن مسعود
عن ذلك عمر بن الخطاب فقال لا تنكحها وفيها شرط وقال حنبل قال عمي كل شرط
في فرج فهو على هذا و الشرط الواحد في البيع جائز إلا أن عمر كره لابن
مسعود أن يطأها لأنه شرط لامرأته الذي شرط فكره عمر أن يطأها وفيها شرط
وقال الكرماني سألت أحمد عن رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيعها ولا
يهبها فكأنه رخص فيه و لكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن
فلا يقربها يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب حين قال لعبد الله بن مسعود
فقد نص في غير موضع على أنه إذا أراد البائع بيعها لم يملك إلا ردها إلى
البائع بالثمن الأول كالمقابلة وأكثر المتأخرين من أصحابه على القول
المبطل لهذا ردها إلى الشرط وربما تأولوا قوله جائز إي العقد جائز و بقية
نصوصه تصرح بأن مراده الشرط أيضا و اتبع في ذلك القصة المأثورة عن عمر و
ابن مسعود و زينب امرأة عبد الله ثلاثة من الصحابة و كذلك اشتراط المبيع
فلا يبيعه ولا يهبه أو يتسراها و نحو ذلك مما فيه تعيين لمصرف واحد كما
روى عمر بن شبه في أخبار عثمان أنه اشترى من صهيب دارا و شرط أن يقفها على
صهيب و ذريته من بعده
و جماع ذلك أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة فكما جاز بالإجماع استثناء
بعض المبيع و جوز أحمد و غيره استثناء بعض منافعه جوز أيضا استثناء بعض
التصرفات
وعلى هذا فمن قال هذا الشرط ينافي مقتضى العقد قيل له أينافي مقتضى العقد
المطلق أو مقتضى العقد مطلقا فإن أراد الأول فكل شرط كذلك و إن أراد
الثاني لم يسلم له و إنما المحذور أن ينافي مقصود العقد كاشتراط الطلاق في
النكاح أو اشتراط الفسخ في العقد فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم ينافي
مقصوده هذا القول هو الصحيح بدلالة الكتاب و السنة و الإجماع و الاعتبار
مع الاستصحاب و عدم الدليل المنافي
أما الكتاب فقال الله تعالى 5 1 { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } و
العقود هي العهود وقال تعالى { وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد
الله أوفوا } و قال تعالى { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا } وقال
تعالى { ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله
مسؤولا } فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود وهذا عام و كذلك أمر بالوفاء
بعهد الله و بالعهد وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله {
ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل } فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده
المرء على نفسه وإن لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد
كالنذر و البيع و إنما أمر بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق في قوله { وإذا
قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا } لأن العدل في القول خبر
يتعلق بالماضي و الحاضر و الوفاء بالعهد يكون في القول المتعلق بالمستقبل
كما قال تعالى { ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من
الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في
قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون } وقال
سبحانه { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } قال المفسرون كالضحاك وغيره تساءلون به تتعاهدون وتتعاقدون وذلك لأن كل واحد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل أو ترك أو مال أو نفع ونحو ذلك وجمع سبحانه في هذه الآية وسائر السورة أحكام الأسباب التي بين بني آدم المخلوقة كالرحم والمكسوبة كالعقود التي يدخل فيها الصهر وولاية مال اليتيم ونحو ذلك وقال سبحانه { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم } والأيمان جمع يمين وكل عقد فإنه يمين قيل سمى بذلك لأنهم كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين يدل على ذلك قوله { إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة } والإل هو القرابة والذمة العهد وهما المذكوران في قوله { تساءلون به والأرحام } إلى قوله { لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة } فذمهم الله على قطيعة الرحم ونقض الذمة إلى قوله { وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم } وهذه نزلت في كفار مكة لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ثم نقضوا العهد بإعانة بني بكر على خزاعة وأما قوله سبحانه { براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين } فتلك عهود جائزة لا لازمة
فإنها كانت مطلقة وكان مخيرا بين إمضائها ونقضها كالوكالة ونحوها ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إن الهدنة لا تصلح إلا مؤقتة فقوله مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر المعاهدين فإنه لم يوقت معهم وقتا فأما من كان من عهده موقتا فلم يبح له نقضه بدليل قوله { إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين } وقال { إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين } وقال { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء } فإنما أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة لأن المحذور من جهتهم وقال تعالى { يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون } الآية و جاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري إن في القرآن الذي نسخت تلاوته سورة كانت كبراءة { يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون } فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة وقال تعالى { والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون } في سورتي المؤمنون و المعارج وهذا من صفة المستثنين من الهلع المذموم بقوله { إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون } هذا يقتضي وجوب ذلك لأنه لم يستثن من المذموم إلا من اتصف بجميع ذلك ولهذا لم يذكر فيها إلا ما هو واجب و كذلك في سورة المؤمنين قال في أولها { أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون } فمن لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين لأن ظاهر الآية
الحصر فإن إدخال الفصل بين المبتدأ و الخبر يشعر الحصر و من لم يكن من وارثي الجنة كان معرضا للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه و إذا كانت رعاية العهد واجبة فرعايته هي الوفاء به ولما جمع الله بين العهد و الأمانة جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضد ذلك صفة المنافق في قوله إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا عاهد غدر و إذا خاصم فجر و عنه كان على خلق من نفاق فطبع المؤمن ليس الخيانة ولا الكذب وما زالوا يوصون بصدق الحديث و أداء الأمانة وهذا عام وقال تعالى { وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل } فذمهم على نقض عهد الله و قطع ما أمر الله بصلته لأن الواجب إما بالشرع و إما بالشرط الذي عقده المرء باختياره وقال أيضا { الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا من ما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار } و قال { أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون } و قال { ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون } وقال تعالى { ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين }
وقال { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا
خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا
يزكيهم ولهم عذاب أليم } وقال تعالى { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم
واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون }
و الأحاديث في هذا كثيرة مثل ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أربع من كن فيه كان منافقا ومن كانت فيه
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف
و إذا عاهد غدر و إذا خاصم فجر ) وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة )
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء
عند استه يوم القيامة وفي رواية وفي رواية ( لكل غادر لواء يوم القيامة
يعرف به بقدر غدرته ألا ولا غادر أعظم غدرة من أمير عامة ) وفي صحيح
مسلم عن بريدة بن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر
أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله و فيمن معه من المسلمين
خيرا ثم قال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا و
لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا و لا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم و كف
عنهم الحديث فنهاهم عن الغدر كما نهاهم عن الغلول
وفي الصحيحين عن ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب لما سأله هرقل عن صفة النبي
صلى الله عليه وسلم هل يغدر فقال لا يغدر و نحن معه في مدة لا ندري ما هو
صانع فيها قال ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة
و قال هرقل في جوابه سألتك هل يغدر فذكرت أنه لا يغدر و كذلك
الرسل لا تغدر فجعل هذا صفة لازمة للمرسلين
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج فدل على استحقاق الشروط بالوفاء
و أن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها
و روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر و رجل باع
حرا ثم أكل ثمنه و رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه و لم يعطه أجره فذم
الغادر و كل من شرط شرطا ثم نقصه فقد غدر
فقد جاء الكتاب و السنة بالأمر بالوفاء بالعهود و الشروط و المواثيق و
العقود و بأداء الأمانة و رعاية ذلك و النهي عن الغدر و نقض العهود و
الخيانة و التشديد على من يفعل ذلك
و لما كان الأصل فيها الحظر و الفساد إلا ما أباحه الشرع لم يجز أن يؤمر
بها مطلقا و يذم من نقضها و غدر مطلقا كما أن قتل النفس لما كان الأصل فيه
الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه لم يجز أن يؤمر بقتل النفس و يحمل على
القدر المباح بخلاف ما كان جنسه واجبا كالصلاة و الزكاة فإنه يؤمر به
مطلقا و إن كان لذلك شروط و موانع فينهى عن الصلاة بغير طهارة وعن الصدقة
بما يضر النفس ونحو ذلك و كذلك الصدق في الحديث مأمور به وإن كان قد يحرم
الصدق أحيانا لعارض و يحج السكوت أو التعريض
و إذا كان جنس الوفاء و رعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود و
الشروط إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره و حصل به مقصوده و مقصود
العقد هو الوفاء به فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل
فيها الصحة و الإباحة
و قد روى أبو داود و الدارقطني من حديث سليمان بن بلال حدثنا
كثير ابن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا و
المسلمون على شروطهم و كثير بن زيد قال يحيى بن معين في رواية هو ثقة و
ضعفه في رواية أخرى
وقد روى الترمذي و البزار من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني
عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الصلح جائز بين
المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ) قال الترمذي حديث حسن صحيح
وروى ابن ماجة منه الفصل الأول لكن كثيرا ابن عمرو ضعفه الجماعة و ضرب
أحمد على حديثه في المسند فلم يحدث به فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من
وجوه وقد روي أبو بكر البزار أيضا عن محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه
عن أبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على شروطهم ما
وافق الحق وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يشد
بعضها بعضا
وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب و السنة وهو حقيقة المذهب فإن المشترط
ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله فإن شرطه حينئذ يكون
مبطلا لحكم الله و كذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله و إنما المشترط له
أن يكون يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه فمقصود الشروط وجوب مالم يكن
واجبا ولا حراما وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب حتى يكون المشترط مناقضا
للشرع وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا فإن المتبايعين
يجب لكل منهما على الآخر من الإقباض ما لم يكن واجبا و يباح أيضل لكل
منهما ما لم يكن مباحا ويحرم على كل منهما ما لم يكن حراما وكذلك كل من
المتآجرين والمتناكحين وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع أو رهنا أو اشترطت
المرأة زيادة على مهر مثلها فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ما
لم يكن كذلك
وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروط قال لأنها إما
تبيح حراما أو تحرم حلالا أو توجب ساقطا أو تسقط واجبا وذلك لا يجوز إلا
بإذن الشارع وأوردت شبهة عند بعض الناس حتى توهم أن هذا الحديث متناقض
وليس كذلك بل كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه كالربا وكالوطء
في ملك الغير وكثبوت الولاء لغير المعتق فإن الله حرم الوطء إلا بملك نكاح
أو ملك يمين فلو أراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطء لم يجز له ذلك بخلاف
إعارتها للخدمة فإنه جائز وكذلك الولاء فقد نهى النبي صلى لله عليه وسلم
عن بيع الولاء وعن هبته وجعل الله الولاء كالنسب يثبت للمعتق كما يثبت
النسب للوالد وقال صلى الله عليه وسلم ( من ادعى إلى غير أبيه أو تولى
غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه
صرفا ولا عدلا ) وأبطل الله ما كانوا عليه في الجاهلية من تبنى الرجل
ابن غيره وانتساب المعتق إلى غير مولاه فهذا أمر لا يجوز فعله بغير شرط
فلا يبيح الشرط منه ما كان حراما وأما ما كان مباحا بدون اشرط فالشرط
يوجبه كالزيادة في المهر والثمن والرهن وتأخير الاستيفاء فإن الرجل له أن
يعطي المرأة وله أن يتبرع بالرهن وبالإنظار ونحو ذلك فإذا شرطه صار واجبا
وإذا وجب فقد حرمت المطالبة التي كانت حلالا بدونه لأن المطالبة لم تكن
حلالا مع عدم الشرط فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقا فما كان حلالا
وحراما مطلقا فالشرط لا يغيره
وأما ما أباحه الله في حال مخصوصة ولم يبحه مطلقا فإذا حوله الشرط عن تلك
الحال لم يكن الشرط قد حرم ما أحله الله وكذلك ما حرمه الله في حال
مخصوصة ولم يحرمه مطلقا لم يكن الشرط قد أباح ما حرمه الله وإن
كان بدون الشرط يستصحب حكم الإباحة والتحريم لكن فرق بين ثبوت الإباحة
والتحريم بالخطاب وبين ثبوته بمجرد الاستصحاب
فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب لكن لا يرفع ما أوجبه كلام الشارع
وآثار الصحابة توافق ذلك كما قال عمر رضى الله عنه مقطع الحقوق عند الشروط
وأما الاعتبار فمن وجوه أحدها أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية
والأصل فيها عدم التحريم فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل ذلك على
التحريم كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم وقوله { وقد فصل لكم ما
حرم عليكم } عام في الأعيان والأفعال وإذا لم يكن حراما لم تكن فاسدة
وكانت صحيحة
وأيضا فليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط إلا ما ثبت حله
بعينه وسنبين إن شاء الله معنى حديث عائشة وأن انتفاء دليل التحريم دليل
على عدم التحريم فثبت بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدليل الشرعي عدم
التحريم فيكون فعلها إما حلالا وإما عفوا كالأعيان التي لم تحرم وغالب ما
يستدل به على أن الأصل في الأعيان عدم التحريم من النصوص العامة والأقيسة
الصحيحة والاستصحاب العقلي وانتفاء الحكم لانتفاء دليله فإنه يستدل به على
عدم تحريم العقود والشروط فيها سواء سمى ذلك حلالا أو عفوا على الاختلاف
المعروف بين أصحابنا وغيرهم فإن ما ذكره الله في القرآن من ذم الكفار على
التحريم بغير شرع منه سببه تحريم الأعيان ومنه ما سببه تحريم الأفعال كما
كانوا يحرمون على المحرم لبس ثيابه والطواف فيها إذا لم يكن احمسيا
ويأمرونه بالتعري إلا أن يعيره احمسى ثوبه ويحرمون عليه الدخول تحت سقف
كما كان الأنصار يحرمون إتيان الرجل امرأته في فرجها إذا كانت
مجنبة ويحرمون الطواف بالصفا والمروة وكانوا مع ذلك قد ينقضون
العهود التي عقدوها بلا شرع فأمرهم الله سبحانه في سورة النحل وغيرها
بالوفاء بها إلا ما اشتمل على محرم
فعلم أن العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة وإن لم يثبت حلها بشرع
خاص كالعهود التي عقدوها في الجاهلية وأمر بالوفاء بها وقد نبهنا على هذه
القاعدة فيما تقدم وذكرنا أنه لا يشرع إلا ما شرعه الله ولا يحرم إلا ما
حرمه الله لأن الله ذم المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله
وحرموا ما لم يحرمه الله فإذا حرمنا العقود والشروط التي تجري بين الناس
في معاملاتهم العادية بغير دليل شرعي كنا محرمين ما لم يحرمه الله بخلاف
العقود التي تتضمن شرع دين لم يأذن به الله فإن الله قد حرم أن يشرع من
الدين مما لم يأذن به فلا يشرع عبادة إلا بشرع الله ولا يحرم عادة إلا
بتحريم الله والعقود في المعاملات هي من العادات يفعلها المسلم والكافر
وإن كان فيها قربة من وجه آخر فليست من العبادات التي يفتقر فيها إلى شرع
كالعتق والصدقة
فإن قيل العقود تغير ما كان مشروعا لأن ملك البضع أو المال إذا كان ثابتا
على حال فعقد عقدا أزاله عن تلك الحال فقد غير ما كان مشروعا بخلاف
الأعيان التي لم تحرم فإنه لا يعتبر في إباحتها
فيقال لا فرق بينهما وذلك أن الأعيان إما أن تكون ملكا لشخص أو لا تكون
فإن كانت ملكا فانتقالها بالبيع إلى غيره لا يغيرها وهو من باب العقود وإن
لم تكن ملكا فملكها بالاستيلاء ونحوه هو فعل من الأفعال مغير لحكمها
بمنزلة العقود
وأيضا فإنها قبل الزكاة محرمة فالزكاة الواردة عليها بمنزلة العقد الوارد
على المال فكما أن أفعالنا في الأعيان من الأخذ والزكاة الأصل فيه الحل
وإن غير
حكم العين فكذلك أفعالنا في الملاك في العقود ونحوها الأصل فيها
الحل وإن غيرت حكم الملك
وسبب ذلك أن الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع وملك البضع
الثابت بالنكاح نحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام والشارع أثبت الحكم لثبوت
سببه منا لم يثبته ابتداء كما أثبت إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات
المبتدأة فإذا كنا نحن المثبتين لذلك الحكم ولم يحرم الشارع علينا رفعه لم
يحرم علينا رفعه فمن اشترى عينا فالشارع أحلها له وحرمها على غيره لإثباته
سبب ذلك وهو الملك الثابت بالبيع وما لم يحرم الشارع عليه ورفع ذلك فله أن
يرفع ما أثبته على أى وجه احب ما لم يحرمه الشارع عليه كمن أعطى رجلا مالا
فالأصل أن لايحرم عليه التصرف فيه وإن كان مزيلا للملك الذي أثبته المعطى
ما لم يمنع مانع وهذا نكتة المسألة التي يتبين بها مأخذها وهو أن الأحكام
الجزئية من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو لم يشرعها الشارع شرعا
جزئيا وإنما شرعها شرعا كليا مثل قوله { وأحل الله البيع وحرم الربا }
وقوله { وأحل لكم ما وراء ذلكم } وقوله { فانكحوا ما طاب لكم من النساء }
وهذا الحكم الكلي ثابت سواء وجد هذا البيع المعين أو لم يوجد فإذا وجد بيع
معين أثبت ملكها معينا فهذا المعين سببه فعل العبد فإذا رفعه العبد فإنما
رفع ما أثبته هو بفعله لا ما أثبته الله من الحكم الجزئي إنما هو تابع
لفعل العبد سببه فقط لأن الشارع أثبته ابتداء
وإنما توهم بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود والفسوخ مثل نسخ الأحكام وليس
كذلك فإن الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته وهو الشارع وأما هذا
المعين فإنما ثبت لأن العبد ادخله في المطلق فإدخاله في المطلق إليه فكذلك
إخراجه إذ الشارع لم يحكم عليه في المعين بحكم أبدا مثل أن يقول هذا الثوب
بعه أو لا تبعه أو هبه أو لا تهبه وإنما حكمه على المطلق الذي إذا أدخل
فيه المعين على حكم المعين
فتدبر هذا وفرق بين تغيير الحكم المعين الخاص الذي أثبته العبد بإدخاله في
المطلق وبين تغيير الحكم العام الذي أثبته الشارع عند وجود سببه من العبد
وإذا ظهر أن العقود لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع فإنما وجب الوفاء بها
لإيجاب الشارع الوفاء بها مطلقا إلا ما خصه الدليل على أن الوفاء بها من
الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل والعقلاء جميعهم وقد أدخلها في
الواجبات العقلية من قال بالوجوب العقلي ففعلها ابتداء لا يحرم إلا بتحريم
الشارع والوفاء بها وجب لإيجاب الشارع إذن ولإيجاب العقل أيضا
وأيضا فإن الأصل في العقود رضى المتعاقدين وموجبها هو ما أوجباه على
أنفسهما بالتعاقد لأن الله قال في كتابه العزيز { إلا أن تكون تجارة عن
تراض منكم } وقال { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } فعلق
جواز الأكل بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه فدل على أنه سبب له وهو حكم
معلق على وصف مشتق مناسب فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم وإذا كان
طيب النفس هو المبيح لأكل الصداق فكذلك سائر التبرعات قياسا عليه بالعلة
المنصوص التي دل عليها القرآن وكذلك قوله { إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم } لم يشترط في التجارة إلا التراضي وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح
للتجارة وإذا كان كذلك فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة أو طابت نفس المتبرع
بتبرع ثبت حله بدلالة القرآن إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله كالتجارة
في الخمر ونحو ذلك
وأيضا فإن العقد له حالان حال إطلاق وحال تقييد ففرق بين العقد المطلق
وبين المعنى المطلق من العقود فإذا قيل هذا شرط ينافي مقتضى العقد فإن
أريد به ينافي العقد المطلق فكذلك كل شرط زائد وهذا لا يضره وإن أريد
ينافى مقتضى العقد المطلق والمقيد احتاج إلى دليل على ذلك وإنما يصح هذا
إذا نافى مقصود العقد فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع
صوره وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود فقد جمع بين المتناقضين بين
إثبات المقصود ونفيه فلا يحصل شئ ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق بل هو مبطل
للعقد عندنا
والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع مثل اشتراط الولاء
لغير المعتق فإن هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصوده الملك والعتق قد
يكون مقصودا للعقد فإن اشتراء العبد لعتقه يقصد كثيرا فثبوت الولاء لا
ينافي مقصود العقد وإنما ينافي كتاب الله وشرطه كما بينه النبي صلى الله
عليه وسلم بقوله ( كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ) فإذا كان الشرط
منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا وإذا كان منافيا لمقصود الشارع كان
مخالفا لله ورسوله فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما فلم يكن لغوا ولا
اشتمل على ما حرمه الله ورسوله فلا وجه لتحريمه بل الواجب حله لأنه عمل
مقصود للناس يحتاجون إليه إذا لولا حاجتهم إليه لما فعلوه فإن الإقدام على
الفعل مظنة الحاجة إليه ولم يثبت تحريمه فيباح لما في الكتاب والسنة مما
يرفع الحرج
وأيضا فإن العقود والشروط لا تخلوا إما أن يقال لا يحل ولا يصح إن لم يدل
على حلها دليل شرعي خاص من نص أو إجماع أو قياس عند الجمهور كما ذكرناه من
القول الأول أو يقال لا تحل وتصح حتى يدل على حلها دليل سمعى وإن كان عاما
أو يقال تصح ولا تحرم إلا يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام
والقول الأول باطل لأن الكتاب والسنة دلا على صحة العقود والقبوض التي
وقعت في حال الكفر وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء
محرم فقال سبحانه في آية الربا { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما
بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } فأمرهم بترك ما بقى لهم من الربا في الذمم
ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا بل مفهوم الآية الذي اتفق العمل عليه
يوجب أنه غير منهي عنه ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط
عام حجة الوداع الربا الذي في الذمم ولم يأمرهم برد المقبوض وقال صلى الله
عليه وسلم ( أيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وأيما قسم أدركه
الإسلام فهو على قسم الإسلام ) وأقر الناس على أنكحتهم التي عقدوها في
الجاهلية ولم يستفصل هل عقد به في عدة أو غير عدة بولى أو بغير ولى بشهود
أو بغير شهود ولم يأمر أحدا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته إلا أن يكون
السبب المحرم موجودا حين الإسلام كما أمر غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم
وتحته عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن وكما أمر فيروزا الديلمي الذي
أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما ويفارق في الأخرى وكما أمر الصحابة من
أسلم من المجوس أن يفارقوا ذوات المحارم ولهذا اتفق المسلمون على أن
العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على
المسلمين وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن الشارع ولو كانت العقود عندهم
كالعبادات لا تصح إلا بشرع لحكموا بفسادها أو بفساد ما لم يكن أهله
مستمسكين فيه بشرع
فإن قيل فقد اتفق فقهاء الحديث وأهل الحجاز على أنها إذا عقدت على وجه
محرم في الإسلام ثم أسلموا بعد زواله ولم يؤمروا باستئنافها لأن الإسلام
يجب ما قبله فليس ما عقدوه بغير شرع دون ما عقدوه مع تحريم الشرع وكلاهما
عندكم سواء
قلنا ليس كذلك بل ما عقدوه مع التحريم إنما يحكم بصحته إذا اتصل به
التقابض وأما إذا أسلموا قبل التقابض فإنه يفسخ بخلاف ما عقدوه يغير شرع
فإنه لا يفسخ لا قبل القبض ولا بعده ولم أر الفقهاء من أصحابها وغيرهم
اشترطوا في النكاح القبض بل سووا بين الإسلام قبل الدخول وبعده لأن نفس
عقد النكاح يوجب أحكاما بنفسه وإن لم يحصل به القبض من المصاهرة
ونحوها كما أن نفس الوطء يوجب أحكاما وإن كان بغير نكاح فلما كان
كل واحد من العقد والوطء مقصودا في نفسه وإن لم يقترن بالآخر أقرهم الشارع
على ذلك بخلاف الأموال فإن المقصود بعقودها هو التقابض فإذا لم يحصل
التقابض لم يحصل مقصودها فأبطلها الشارع لعدم حصول المقصود
فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يبطله الشارع إلا مع التحريم
لأنه لا يصححه إلا بتحليل
وأيضا فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودا ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها
ولا تحليلها فإن الفقهاء جميعهم فيما أعلمه يصححونها إذا لم يعتقدوا
تحريمها وإن كان العاقد لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد
ولا يقول أحد لا يصح العقد إلا الذي يعتقد العاقد أن الشارع أحله فلو كان
إذن الشارع الخاص شرطا في صحة العقود لم يصح عقد إلا بعد ثبوت إذنه كما لو
حكم الحاكم بغير اجتهاد فإنه آثم وإن كان قد صادف الحق
وأما إن قيل لا بد من دليل شرعي يدل على حلها سواء كان عاما أو خاصا فعنه
جوابان
أحدهما المنع كما تقدم والثاني أن نقول قد دلت الأدلة الشرعية العامة على
حل العقود والشوط جملة إلا ما استثناه الشارع وما عرضوا به سنتكلم عنه إن
شاء الله فلم يبقى إلا القول الثالث وهو المقصود
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن
كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ) فالشرط يراد به المصدر
تارة والمفعول أخرى وكذلك الوعد والخلف ومنه قولهم درهم ضرب الأمير
والمراد به هنا والله أعلم المشروط لا نفس التكلم ولهذا قال ( وإن كان
مائة شرط ) أى وإن كان قد شرط مائة شرط وليس المراد تعديد التكلم بالشرط
وإنما المراد تعديد الشروط والدليل على ذلك قوله
( كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ) أى كتاب الله أحق من هذا
الشرط وشرط الله أوثق منه وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله
وشرطه بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى
وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله فلم يخالف كتاب الله وشرطه حتى
يقال كتاب الله أحق وشرط الله أوثق فيكون المعنى من اشترط أمرا ليس في حكم
الله ولا في كتابه بواسطة وبغير واسطة فهو باطل لأنه لا بد أن يكون
المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط ولما لم
يكن في كتاب الله أن الولاء لغير المعتق أبدا كان هذا المشروط وهو ثبوت
الولاء لغير المعتق شرطا ليس في كتاب الله فانظر إلى المشروط إن كان أصلا
أو حكما فإن كان الله قد أباحه جاز اشتراطه ووجب وإن كان الله لم يبحه لم
يجز اشتراطه فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله
لأن كتاب الله يبيح أن لا يسافر بها فإذا شرط عدم السفر فقد شرط مشروطا
مباحا في كتاب الله
فمضمون الحديث أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة أو يقال ليس في
كتاب الله أى ليس في كتاب الله نفيه كما قال سيكون أقوام يحدثونكم بما لا
تعرفون أنتم ولا آباؤكم أى بما تعرفون خلافه وإلا فما لا يعرف كثير
ثم نقول إذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن العقود والشروط التي لم
يبحها الشارع تكون باطلة بمعنى أنه لا يلزم بها شئ لا إيجاب ولا تحريم فإن
هذا خلاف الكتاب والسنة بل العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام فإن
الله قد حرم عقد الظهار في نفس كتابه وسماه منكرا من القول وزورا ثم إنه
أوجب به على من عاد الكفارة ومن لم يعد جعل في حقه مقصود التحريم من ترك
الوطء أو ترك العقد وكذا النذر فإن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن النذر كما ثبت عنه من حديث أبي هريرة و ابن عمر فقال
إنه لا يأتي بخير ثم أوجب الوفاء به إذا كان طاعة في قوله صلى الله عليه
وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه
فالعقد المحرم قد يكون سببا لإيجاب أو تحريم نعم لا يكون سببا لإباحة كما
أنه لما نهى عن بيوع الغرر و عن عقد الربا وعن نكاح ذوات المحارم ونحو ذلك
لم يستفد المنهي عنه الاستباحة لأن المنهي عنه معصية و الأصل في المعاصي
أنها لا تكون سببا لنعمة الله و رحمته و الإباحة من نعمة الله و رحمته و
إن كانت قد تكون سببا للإملاء و لفتح أبواب الدنيا لكن ذلك قدر ليس بشرع
بل قد يكون سببا لعقوبة الله و الإيجاب و التحريم قد يكون عقوبة كما قال
الله تعالى { فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم } وإن كان
قد يكون رحمة أيضا كما جاءت شريعتنا الحنيفية
و المخالفون في هذه القاعدة من أهل الظاهر و نحوهم قد يجعلون كل ما لم
يؤذن فيه إذن خاص فهو عقد حرام و كل عقد حرام فوجوده كعدمه و كلا
المقدمتين ممنوعة كما تقدم
وقد يجاب عن هذه الحجة بطريقة ثانية إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد
الشروط التي لم يبحها وإن كان لم يحرمها باطلة فنقول
قد ذكرنا ما في الكتاب و السنة والآثار من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء
بالعهود و الشروط عموما و أن المقصود هو وجوب الوفاء بها وعلى هذا التقدير
فوجوب الوفاء بها يقتضي أن تكون مباحة فإنه إذا وجب الوفاء بها لم تكن
باطلة و إذا لم تكن باطلة كانت مباحة وذلك لأن قوله ليس في كتاب الله إنما
يشمل ما ليس في كتاب الله لا بعمومه ولا بخصوصه وإنما دل كتاب الله على
إباحته بعمومه فإنه في كتاب الله لأن قولنا هذا في كتاب الله يعم ما هو
فيه بالخصوص أو بالعموم و على هذا معنى قوله تعالى { ونزلنا عليك الكتاب
تبيانا لكل شيء }
وقوله { ولكن تصديق الذي بين يديه } وقوله { ما فرطنا في الكتاب
من شيء } على قول من جعل الكتاب هو القرآن وأما على قول من جعل اللوح
المحفوظ فلا يجيء ههنا
يدل على ذلك أن الشرط الذي بينا جوازه بسنة أو إجماع صحيح بالاتفاق فيجب
أن يكون في كتاب الله وقد لا يكون في كتاب الله بخصوصه لكن في كتاب الله
الأمر باتباع السنة و اتباع سبيل المؤمنين فيكون في كتاب الله بهذا
الاعتبار لأن جامع الجامع جامع و دليل الدليل دليل بهذا الاعتبار
يبقى أن يقال على هذا الجواب فإذا كان كتاب الله أوجب الوفاء بالشروط
عموما فشرط الولاء داخل في العموم
فيقال العموم إنما يكون دالا إذا لم ينفعه دليل خاص فإن الخاص يفسر العام
وهذا المشروط قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن بيع الولاء وعن
هبته وقوله ( من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنه الله
و الملائكة و الناس أجمعين ) و دل الكتاب على ذلك بقوله تعالى { ما جعل
الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم
وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي
السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في
الدين ومواليكم } فأوجب علينا دعاءه لأبيه الذي ولده دون من تبناه و حرم
التبني ثم أمر عند عدم العلم بالأب بأن يدعي أخاه في الدين ومولاه كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة ( أنت أخونا و مولانا ) وقال
صلى الله عليه وسلم ( إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه
تحت يده فليطعمه مما يأكل و ليكسه مما يلبس )
فجعل سبحانه الولاء نظير النسب و بين سبب الولاء في قوله { وإذ تقول للذي
أنعم الله عليه وأنعمت عليه } فبين أن سبب الولاء هو الإنعام بالإعتاق كما
أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد فإذا كان قد حرم الانتقال
عن المنعم بالإيلاد فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالأعتاق لأنه
في معناه فمن اشترط على المشتري أن يعتق و يكون الولاء لغيره فهو كمن
اشترط على المستنكح أنه إذا أولد كان النسب لغيره
و إلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه و سلم في قوله ( إنما الولاء
لمن أعتق )
و إذا كان كتاب الله قد دل على تحريم هذا المشروط بخصوصه و عمومه لم يدخل
في العهود التي أمر الله بالوفاء بها لأنه سبحانه لا يأمر بما حرمه مع أن
الذي يغلب على القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا المعنى الأول
وهو إبطال الشروط التي تنافي كتاب الله و التقدير من اشترط شيئا لم يبحه
الله فيكون المشروط قد حرمه لأن كتاب الله قد أباح عموما لم يحرمه أو من
اشترط ما ينافي كتاب الله بدليل قوله ( كتاب الله أحق و شرط الله أوثق )
) فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود و الشروط جملة و صحتها أصلان الأدلة
الشرعية العامة و الأدلة العقلية التي هي الاستصحاب و انتفاء المحرم فلا
يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل و أعيانها إلا بعد
الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي
التحريم أم لا
أما إذا كان المدرك الاستصحاب و نفي الدليل الشرعي فقد أجمع المسلمون وعلم
بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد و يفتي بموجب هذا
الاستصحاب و النفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك فإن
جميع ما أوجبه الله و رسوله وحرمه الله ورسوله مفسر لهذا الاستصحاب فلا
يوثق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو من أهل ذاك و أما إذا كان
المدرك هو النصوص العامة فالعام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز
التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة هل هي من المستخرج أو من المستبقي
وهذا أيضا لا خلاف فيه و إنما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم
تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة فيه هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل
البحث عن المخصص المعارض له فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي و
أحمد و غيرهما و ذكروا عن أحمد فيه روايتين و أكثر نصوصه على أنه لا يجوز
لأهل زمانه و نحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة و
أقوال الصحابة و التابعين و غيرهم وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب
و غيره فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على
الظن مقتضاه فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه وهذا
الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض سواء
جعل عدم المعارض جزءا من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر المجرد عن القرينة
كما يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل ولا العلة من أصحابنا و غيرهم أو جعل
المعارض باب المانع للدليل فيكون الدليل هو الظاهر لكن القرينة مانعة
لدلالته كما يقوله من يقول بتخصيص الدليل و العلة من أصحابنا و غيرهم و إن
كان الخلاف في ذلك إنما يعود إلى اعتبار عقلي أو إطلاق لفظي أو اصطلاح
جدلي لا يرتفع إلى أمر علمي أو فقهي
فإذا كان كذلك فالأدلة النافية لتحريم العقود و الشروط و المثبتة لحلها
مخصوصة بجميع ما حرمه الله و رسوله من العقود و الشروط فلا ينتفع بهذه
القاعدة في أنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك النوع فهي
بأصول الفقه التي هي الأدلة العامة أشبه منها بقواعد الفقه التي هي
الأحكام العامة
نعم من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافية أو حادثة
انتفع بهذه القاعدة فنذكر من أنواعها قواعد حكمية مطلقة
فمن ذلك ما ذكرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عينا من ملكه بمعاوضة كالبيع و
الخلع أو تبرع كالوقف و العتق أن يستثني بعض منافعها مما لا يصلح فيه
القربة كالبيع فلا بد أن يكون المستثنى معلوما لما روى البخاري و أبو داود
و الترمذي و النسائي عن جابر قال بعته يعني بعيره من النبي صلى الله
عليه وسلم و اشترطت حملانه إلى أهلي و إن لم يكن كذلك كالعتق و
الوقف فله أن يستثني خدمة العبد ما عاش سيده أو عاش فلان و يستثني غلة
الوقف ما عاش الواقف
ومن ذلك أن البائع إذا شرط على المشتري أن يعتق العبد صح ذلك في ظاهر مذهب
الشافعي و أحمد و غيرهما لحديث بريرة و إن كان عنهما قول بخلافه
ثم هل يصير العتق واجبا على المشتري كما يجب العتق بالنذر بحيث يفعله
الحاكم إذا امتنع أم يملك البائع الفسخ عند امتناعه من العتق كما يملك
الفسخ بفوات الصفة المشروطة في المبيع على وجهين في مذهبهما ثم الشافعي و
طائفة من أصحاب أحمد يرون هذا خارجا عن القياس لما فيه من منع المشتري من
التصرف في ملكه بغير العتق و ذلك مخالف لمقتضى العقد فإن مقتضاه الملك
الذي يملك صاحبه التصرف مطلقا
قالوا و إنما جوزته السنة لأن الشارع له إلى العتق تشوف لا يوجد في غيره و
لذلك أوجب فيه السراية مع ما فيه من إخراج ملك الشريك بغير اختياره و إذا
كان مبناه على التغليب و السراية و النفوذ في ملك الغير لم يلحق به غيره
فلا يجوز اشتراط غيره
و أصول أحمد و نصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح و إن كان فيه
منع من غيره قال ابن القاسم قيل لأحمد الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها
فأجازه فقيل له فإن هؤلاء يعني أصحاب أبي حنيفة يقولون لا يجوز البيع على
هذا الشرط قال لم لا يجوز قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعير جابر و
اشترط ظهره إلى المدينة و اشترت عائشة بريرة على أن تعتقها فلم لا يجوز
هذا قال و إنما هذا شرط واحد و النهي إنما هو عن شرطين قيل له فإن شرط
شرطين أيجوز قال لا يجوز
فقد نازع من منع منه و استدل على جوازه باشتراط النبي صلى الله عليه وسلم
ظهر البعير لجابر و بحديث بريرة و بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى
عن شرطين في بيع مع أن حديث جابر فيه استثناء بعض منفعة المبيع وهو نقص
لموجب العقد المطلق و اشتراط العتق فيه تصرف مقصود مستلزم لنقص موجب العقد
المطلق
فعلم أنه لا يفرق بين أن يكون النقص في التصرف أو في المملوك و استدلاله
بحديث الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كله ولو كان العتق على خلاف القياس
لما قاسه على غيره ولا استدل عليه بما يشمله و غيره
وكذلك قال أحمد بن الحسين بن حسان سألت أبا عبد الله عمن اشترى مملوكا و
اشترط هو حر بعد موتي قال هذا مدبر فجوز اشتراط التدبير كالعتق و لأصحاب
الشافعي في شرط التدبير خلاف صحح الرافعي أنه لا يصح
و كذلك جوز اشتراط التسري فقال أبو طالب سألت أحمد عن رجل اشترى جارية
بشرط أن يتسرى بها تكون نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بها ولا تكون للخدمة قال
لا بأس به فلو كان التسري للبائع و للجارية فيه مقصود صحيح جوزه
وكذلك جوز أن يشترط بائع الجارية و نحوها على المشتري أنه لا يبيعها لغير
البائع و أن البائع يأخذها إذا أراد المشتري بيعها بالثمن الأول كما رووه
عن عمر و ابن مسعود و امرأته زينب
وجماع ذلك أن المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه و منافعه يملكان
اشتراط الزيادة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من باع نخلا قد
أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) فجوز للمشتري اشتراط زيادة
على موجب العقد المطلق وهو جائز بالإجماع و يملكان اشتراط النقص منه
بالاستثناء كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم فدل
على جوازها إذا
علمت و كما استثنى جابر ظهر بعيره إلى المدينة
و قد أجمع المسلمون فيما أعلمه على جواز استثناء الجزء الشائع مثل مثل أن
يبيعه الدار إلا ربعها أو ثلثها و استثناء الجزء المعين إذا أمكن فصله
بغير ضرر مثل أن يبيعه ثمر البستان إلا نخلات بعينها أو الثياب أو العبيد
أو الماشية التي قد رأياها إلا شيئا منها قد عيناه
و اختلفوا في استثناء بعض المنفعة كسكنى الدار شهرا أو استخدام العبد شهرا
أو ركوب الدابة مدة معينة أو إلى بلد بعينه مع اتفاق الفقهاء المشهورين و
أتباعهم و جمهور الصحابة على أن ذلك قد يقع كما إذا اشترى أمة مزوجة فأن
منفعة بضعها التي يملكها الزوج لم تدخل في العقد كما اشترت عائشة بريرة و
كانت مزوجة لكن هي اشترتها بشرط العتق فلم تملك التصرف فيها إلا بالعتق و
العتق ينافي نكاحها فلذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو ممن روى حديث
سريره يرى أن بيع الأمة طلاقها مع طائفة من الصحابة تأويلا لقوله تعالى {
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قالوا فإذا ابتاعها أو اتهبها
أو ورثها فقد ملكتها يمينه فتباح له ولا يكون ذلك إلا بزوال ملك الزوج و
احتج بعض الفقهاء على ذلك بحديث بريرة
فلم يرض أحمد هذه الحجة لأن ابن عباس رواه و خالفه و ذلك و الله أعلم لما
ذكرته من أن عائشة لم تملك بريرة ملكا مطلقا
ثم الفقهاء قاطبة و جمهور الصحابة على أن الأمة المزوجة إذا انتقل الملك
فيها ببيع أو هبة أو إرث أو نحو ذلك وكان مالكها معصوم الملك لم يزل عنها
ملك الزوج و ملكها المشتري و نحوه إلا منفعة البضع
ومن حجتهم أن البائع نفسه لو أراد أن يزيل ملك الزوج لم يمكنه ذلك
فالمشتري الذي هو دون البائع لا يكون أقوى منه ولا يكون الملك الثابت
للمشتري أتم من البائع و الزوج معصوم لا يجوز الاستيلاء على حقه بخلاف
المسبية
فإن فيها خلافا ليس هذا موضعه لكون أهل الحرب تباح دماؤهم و
أموالهم و كذلك ما ملكوه من الأبضاع
و كذلك فقهاء الحديث و أهل الحجاز متفقون على أنه إذا باع شجرا قد بدا
ثمره كالنخل المؤبر فثمره للبائع مستحق الإبقاء إلى كمال صلاحه فيكون
البائع قد استثنى منفعة الشجر إلى كمال الصلاح و كذلك 3 بيع العين المؤجرة
كالدار و العبد عامتهم يجوزه و يملكه المشتري دون المنفعة التي للمستأجر
فقهاء الحديث كأحمد و غيره يجوزون استثناء بعض منفعة العقد كما في صور
الوفاق و كاستثناء بعض أجزاءه معينا و مشاعا و كذلك يجوزون استثناء بعض
أجزائه معينا إذا كانت العادة جارية بفصله كبيع الشاة و استثناء بعضها
سواء قطعها من الرأس و الجلد و الأكارع و كذلك الإجارة فإن العقد المطلق
يقتضي نوعا من الانتفاع في الإجارات المقدرة بالزمان كما لو استأجر أرضا
للزرع أو حانوتا لتجارة فيه أو صناعة أو أجير لخياطة أو بناء و نحو ذلك
فإنه لو زاد على موجب العقد المطلق أو نقص عنه فإنه يجوز بغير خلاف أعلمه
في النكاح فإن العقد المطلق يقتضي ملك الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف
حيث شاء و متى شاء فينقلها إلى حيث شاء إذا لم يكن فيه ضرر إلا ما استثناه
من الاستمتاع المحرم الذي هو مهر المثل و ملكها للاستمتاع في الجملة فإنه
لو كان مجبوبا أو عنينا ثبت لها الفسخ عند السلف و الفقهاء و المشاهير و
لو آلى منها ثبت لها فراقه إذا لم يفئ بالكتاب و الإجماع و إن كان من
الفقهاء من لا يوجب عليه الوطء و قسم الابتداء بل يكتفي بالباعث الطبيعي
كمذهب أبي حنيفة و الشافعي و رواية عن أحمد فإن الصحيح من وجوه كثيرة أنه
يجب عليه الوطء و القسم كما دل عليه الكتاب و السنة و آثار الصحابة و
الاعتبار و قيل يتقدر الوطء الواجب بمرة كل أربعة أشهر اعتبارا بالإبلاء و
يجب إن يطأها بالمعروف كما ينفق عليها بالمعروف فيه خلاف في مذهب أحمد و
غيره و الصحيح الذي يدل
عليه أكثر نصوص أحمد و عليه أكثر السلف أن ما يوجبه العقد لكل
واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة و الاستمتاع و المبيت للمرأة و
كالاستمتاع للزوج ليس بمقدر بل المرجع في ذلك إلى العرف كما دل عليه
الكتاب في مثل قوله تعالى { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } و السنة في
مثل قوله صلى الله عليه وسلم لهند ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) و
إذا تنازع الزوجان فيه فرض الحاكم باجتهاده كما فرضت الصحابة مقدار الوطء
للزوج بمرات معدودة ومن قدر من أصحاب أحمد الوطء المستحق فهو كتقدير
الشافعي النفقة إذ كلاهما تحتاجه المرأة و يوجبه العقد و تقدير ذلك ضعيف
عند عامة الفقهاء بعيد عن معاني الكتاب و السنة و الاعتبار و الشافعي إنما
قدره طردا للقاعدة التي ذكرناها عنه من نفيه للجهالة في جميع العقود قياسا
على المنع من بيع الغرر فجعل النفقة المستحقة بعقد النكاح مقدرة طردا لذلك
وقد تقدم التنبيه على هذا الأصل
وكذلك يوجب العقد المطلق سلامة الزوج من الجب و العنة عند عامة الفقهاء و
كذلك يوجب عند الجمهور سلامتها من موانع الوطء كالرتق و سلامتها من الجنون
و الجذام و البرص و كذلك سلامتها من العيوب التي تمنع كماله كخروج
النجاسات منه أو منها ونحو ذلك في أحد الوجهين في مذهب أحمد و غيره دون
الجمال و نحو ذلك و موجبه كفاءة الرجل أيضا دون ما زاد على ذلك
ثم لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة كالمال و الجمال و البكارة
ونحو ذلك صح ذلك و ملك المشترط الفسخ عند فواته في أصح الرواية عند أحمد
أو أصح وجهي أصحاب الشافعي و ظاهر مذهب مالك و الرواية الأخرى لا يملك
الفسخ إلا في شرط الحرية و الدين وفي شرط النسب على هذه الرواية وجهان
سواء كان المشترط هو المرأة في الرجل أو الرجل في المرأة بل اشتراط المرأة
في الرجل أوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب أحمد و غيرهم و ما ذكره بعض أصحاب
أحمد بخلاف ذلك لا أصل له
و كذلك لو اشترط بعض الصفة المستحقة بمطلق العقد مثل أن يشترط الزوج أنه
مجبوب أو عنين أو المرأة أنها رتقاء أو مجنونة صح هذا الشرط باتفاق
الفقهاء فقد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب العقد و اختلفوا في شرط
الزيادة عليه في هذا الموضع كما ذكرته لك فإن مذهب أبي حنيفة أنه لا يثبت
للرجل خيار عيب ولا شرط في النكاح و أما المهر فإنه لو زاد على مهر المثل
أو نقص جاز بالاتفاق
كذلك يجوز أكثر السلف أو كثير منهم و فقهاء الحديث و مالك في إحدى
الروايتين أن ينقص ملك الزوج فتشترط عليه أن لا ينقلها من بلدها أو من
دارها و أن يزيدها على ما تملكه بالمطلق صرفوا عليها نفسه فلا يتزوج عليها
ولا يتسرى وعند طائفة من السلف و أبي حنيفة و الشافعي و مالك في الرواية
الأخرى لا يصح هذا الشرط لكنه له عند أبي حنيفة و الشافعي أثر في تسمية
المهر
و القياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد و غيره من فقهاء
الحديث أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد و اشتراط النقص جائز ما لم يمنع
منه الشرع فإذا كانت الزيادة في العين أو المنفعة المعقود عليها و النقص
من ذلك ما ذكرت فالزيادة في الملك المستحق بالعقد و النقص منه كذلك فإذا
شرط على المشتري أن يعتق العبد أو يقف العين على البائع أو غيره أو أن
يقضي بالعين دينا عليه لمعين أو غير معين أو أن يصل به رحمه ونحو ذلك فهو
اشتراط تصرف مقصود و مثله التبرع المفروض و التطوع
و أما التفريق بين العتق و غيره بما في العتق من الفضل الذي يتشوفه الشارع
فضعيف فإن بعض أنواع التبرعات أفضل منه فإن صلة ذي الرحم المحتاج أفضل منه
كما نص عليه أحمد فإن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت
جارية لها فقال النبي صلى الله عليه سلم ( لو تركتيها لأخوالك
لكان خيرا لك ) و لهذا لو كان للميت أقارب لا يرثون كانت الوصية لهم
أولى من الوصية بالعتق وما أعلم في هذا خلافا وإنما أعلم الاختلاف في وجوب
الوصية لهم فإن فيه عن أحمد روايتين إحداهما تجب كقول طائفة من السلف و
الخلف و الثانية لا تجب كقول الفقهاء الثلاثة و غيرهم ولو وصى لغيرهم
دونهم فهل تسري تلك الوصية على أقاربه دون الموصي له أو يعطى ثلثها للموصى
له و ثلثاها لأقاربه كما تقسم التركة بين الورثة و الموصى له على روايتين
عن أحمد و إن كان المشهور عند أكثر أصحابه هو القول بنفوذ الوصية فإذا كان
بعض التبرعات أفضل من العتق لم يصح تعليله باختصاصه بمزيد الفضيلة
و أيضا فقد يكون المشروط على المشتري أفضل كما لو كان عليه دين لله من
زكاة أو كفارة أو نذر أو دين لآدمي فاشترط عليه وفاء دينه من ذلك المبيع
أو اشترط المشتري على البائع وفاء الدين الذي عليه من الثمن ونحو ذلك فهذا
أوكد من اشتراط العتق
و أما السرية فإنما كانت لتكميل الحرية وقد شرع مثل ذلك في الأموال وهو حق
الشفعة فإنها شرعت لتكميل الملك للمشتري لما في الشركة من الضرار ونحن
نقول شرع ذلك في جميع المشاركات فيمكن الشريك من المقاسمة فإن أمكن قسمة
العين و إلا قسمنا ثمنها إذا طلب أحدهما ذلك فتكميل العتق نوع من ذلك إذ
الشركة تزول بالقسمة تارة و بالتكميل أخرى
و أصل ذلك أن الملك هو القدرة الشرعية على التصرف بمنزلة القدرة الحسية
فيمكن أن تثبت القدرة على التصرف دون تصرف شرعا كما يثبت ذلك حسا و لهذا
جاء الملك في الشرع أنواعا كما أن القدرة تتنوع أنواعا فالملك التام يملك
فيه التصرف في الرقبة بالبيع و الهبة و يورث عنه و يملك التصرف في منافعه
بالإعارة و الإجارة و الانتفاع و غير ذلك ثم قد يملك الأمة المجوسية
أو المحرمات عليه بالرضاع فلا يملك منهن الاستمتاع و يملك
المعاوضة عليه بالتزويج بأن يزوج المجوسية المجوسي مثلا و قد يملك أم
الولد ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا تورث عنه عند جماهير المسلمين و يملك
وطأها و استخدامها باتفاقهم و كذلك تملك المعاوضة على ذلك بالتزويج و
الإجارة عند أكثرهم كأبي حنيفة و الشافعي و أحمد
و يملك المرهون و يجب عليه مؤونته ولا يملك من التصرف ما يزيل حق المرتهن
لا ببيع و لا هبة و في العتق خلاف مشهور
و العبد المنذور عتقه و الهدي و المال الذي قد نذر الصدقة بعينه و نحو ذلك
مما استحق صرفه إلى القربة قد اختلف فيه الفقهاء من أصحابنا و غيرهم هل
يزال ملكه عنه بذلك أم لا و كلا القولين خارج عن قياس الملك المطلق فمن
قال لم يزل ملكه عنه كما قد يقوله أكثر أصحابنا فهو ملك لا يملك صرفه إلا
إلى الجهة المعينة بالإعتاق أو النسك أو الصدقة وهونظير العبد المشترى
بشرط العتق أو الصدقة أو الصلة أو الفدية المشتراة بشرط الإهداء إلى الحرم
ومن قال زال ملكه عنه فإنه يقول هو الذي يملك عتقه و إهداءه و الصدقة به
وهو أيضا خلاف قياس زوال الملك في غير هذا الموضع و كذلك اختلاف الفقهاء
في الوقف على معين هل يصير الموقوف ملكا لله أو ينتقل إلى الموقوف عليه أو
يكون باقيا على ملك الواقف على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد و غيره
وعلى كل تقدير فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك في البيع أو الهبة
و كذلك ملك الموهوب له حيث يجوز للوهب الرجوع كالأب إذا وهب لابنه عند
فقهاء الحديث كالشافعي و أحمد نوع مخالف لغيره حيث سلط غير المالك على
انتزاعه منه و فسخ عقده
و نظيره سائر الأملاك في عقد يجوز لأحد المتعاقدين فسخه كالمبيع بشرط
عند من يقول انتقل إلى المشتري كالشافعي و أحمد في أحد قوليهما
وكالمبيع إذا أفلس المشتري بالثمن عند فقهاء الحديث و أهل الحجاز وكالمبيع
الذي ظهر فيه عيب أو فوات صفة عند جميع المسلمين فهنا في المعاوضة و
التبرع يملك العقد انتزاعه و ملك الأب لا يملك انتزاعه و جنس الملك
يجمعهما و كذلك ملك الابن في مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث الذي اتبعوا
فيه معني الكتاب و صريح السنة
و طوائف من السلف يقولون هو مباح للأب مملوك للابن بحيث يكون للأب
كالمباحات التي تملك بالاستيلاء و ملك الابن ثابت عليه بحيث يتصرف فيه
تصرفا مطلقا فإذا كان الملك يتنوع أنواعا وفيه من الإطلاق و التقييد ما
وصفته و ما لم أصفه لم يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضا إلى الإنسان يثبت منه
ما رأى فيه مصلحة له و يمتنع من إثبات ما لا مصلحة له فيه و الشارع لا
يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض فإذا لم يكن فيه فساد أو
كان فساده مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبدا
فصل
القاعدة الرابعة أن الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له في ظاهر مذهب فقهاء الحديث أحمد و غيره و مذهب أهل المدينة مالك و غيره وهو قول في مذهب الشافعي نص عليه في صداق السر و العلانية و نقلوه إلى شرط التحليل المتقدم و غيره و إن كان المشهور من مذهبه و مذهب أبي حنيفة أن المتقدم لا يؤثر بل يكون كالوعد المطلق عندهم يستحب الوفاء به وهو قول في مذهب أحمد قد يختاره في بعض المواضع طائفة من أصحابه كاختيار بعضهم أن التحليل المشروط قبل العقد لا يؤثر إلا أن ينويه الزوج وقت العقد وقول طائفةكثيرة بما نقلوه عن أحمد من أن الشرط المتقدم على العقد في الصداق لا يؤثر و إنما يؤثر تسميته في العقد ومن أصحاب أحمد طائفة كالقاضي أبي يعلى يفرقون بين الشرط المتقدم الرافع لمقصود العقد و المقيد له فإن كان رافعا كالمواطأة على كون العقد تلجئة أو تحليلا أبطله و إن كان مقيدا له كاشتراط كون المهر أقل من المسمى لم يؤثر فيه لكن المشهور في نصوص أحمد و أصوله وما عليه قدماء أصحابه كقول أهل المدينة أن الشرط المتقدم كالشرط المقارن فإذا اتفقا على شيء و عقد العقد بعد ذلك فهو مصروف إلى المعروف بينهما مما اتفقا عليه كما ينصرف الدرهم و الدينار في العقود إلى المعروف بينهما وكما أن جميع العقود و إنما تنصرف إلى ما يتعارفه المتعاقدان
فصل
القاعدة الخامسة في الأيمان و النذورقال الله تعالى { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم } وقال تعالى { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم } وقال تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } و قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك }
و فيها قواعد عظيمة لكن تحتاج إلى تقديم مقدمات نافعة جدا في هذا الباب و
غيره
المقدمة الأولى أن اليمين تشتمل على جملتين جملة مقسم بها و جملة مقسم
عليها و مسائل الأيمان إما في حكم المحلوف به و إما في حكم المحلوف عليه
فأما المحلوف به فالأيمان التي يحلف بها المسلمون مما قد يلزم بها حكم ستة
أنواع ليس لها سابع
أحدها اليمين بالله و ما في معناها مما فيه التزام كفر على تقدير الحنث
كقوله هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا على ما فيه من الخلاف بين الفقهاء
الثاني اليمين بالنذر الذي يسمى نذر اللجاج و الغضب كقوله علي الحج لا
أفعل كذا أو إن فعلت كذا فعلي الحج أو مالي صدقة إن فعلت كذا و نحو ذلك
الثالث اليمين بالطلاق
الرابع اليمين بالعتاق
الخامس اليمين بالحرام كقوله الحل علي حرام لا أفعل كذا
السادس الظهار كقوله أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا
فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون مما فيه حكم
فأما الحلف بالمخلوقين كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو
بالسيف أو بحياة أحد من المخلوقات فما أعلم بين العلماء خلافا أن هذه
اليمين مكروهة منهي عنها و أن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة وهل الحلف
بها محرم أو مكروه كراهة تنزيه فيه قولان في مذهب أحمد و غيره
أصحهما أنه محرم ولهذا قال أصحابنا كالقاضي أبي يعلى وغيره أنه
إذا قال أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا لزمه اليمين بالله والنذر
والطلاق والعتاق والظهار ولم يذكر الحرام لأن يمين الحرام ظهار عند أحمد
وأصحابه فلما كان موجبها واحد عندهم دخل الحرام في الظهار ولم يدخلوا
النذر في اليمين بالله وإن جاز أن يكفر يمينه بالنذر لأن موجب الحلف
بالنذر المسمى بنذر اللجاج والغضب عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين
فعل المنذور وموجب اليمين بالله هو التكفير فقط فلما اختلف موجهما جعلوهما
يمينين
نعم إذا قالوا بالرواية الأخرى عن أحمد وهو أن الحلف بالنذر موجبه الكفارة
فقط دخلت اليمين بالنذر في اليمين بالله
و أما اختلافهم و اختلاف غيرهم من العلماء في أن مثل هذا الكلام هل ينعقد
به اليمين أو لا ينعقد فسأذكره إن شاء الله تعالى و إنما غرضي هنا حصر
الأيمان التي يحلف بها المسلمون
و أما أيمان البيعة فقالوا أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي و كانت
السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه
وسلم يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع و النكاح و نحوهما إما أن يذكروا
الشروط التي يبايعون عليها ثم يقولون بايعناك على ذلك كما بايعت الأنصار
النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة فلما أحدث الحجاج ما أحدث من الفسق
كان من جملته أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق و
العتاق و اليمين بالله صدقة المال فهذه الأيمان الأربعة هي كانت أيمان
البيعة القديمة المبتدعة ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء و الملوك و غيرهم
أيمانا كثيرة أكثر من ذلك وقد تختلف فيها عاداتهم ومن أحدث ذلك فعليه إثم
ما ترتب على هذه الأيمان من الشر
المقدمة الثانية أن تخرج اليمين عن هاتين الصيغتين فالأول كقوله
و الله لا أفعل كذا أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا أو الحل علي
حرام لا أفعل كذا أو علي الحج لا أفعل كذا و الثاني كقوله إن فعلت كذا
فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو
إن فعلت كذا فعلي الحج أو فما لي صدقة و لهذا عقد الفقهاء لمسائل الأيمان
بابين أحدهما باب تعليق الطلاق بالشروط فيذكرون فيه الحلف بصيغة الجزاء
كإن و إذا و متى أشبه ذلك و إن دخل فيه صيغة القسم ضمنا و تبعا و الباب
الثاني باب جامع الأيمان مما يشترك فيه اليمين بالله و الطلاق و العتاق و
غير ذلك فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم و إن دخلت صيغة الجزاء ضمنا و تبعا
و مسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الباب الآخر لاتفاقهما في المعنى كثيرا
أو غالبا و لذلك كان طائفة من الفقهاء كأبي الخطاب و غيره لما ذكروا في
كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط أردفوه بباب جامع الأيمان و طائفة
أخرى كالخرقى و القاضي أبي يعلى و غيرهما إنما ذكروا باب جامع الأيمان في
كتاب الأيمان لأنه به أمس و نظير هذا الباب حد القذف منهم من يذكره عند
باب اللعان لاتصال أحدهما بالآخر و منهم من يؤخره إلى كتاب الحدود لأنه به
أخص
و إذا تبين أن لليمين صيغتين صيغة القسم و صيغة الجزاء فالمقدم صيغة القسم
مؤخر في صيغة الجزاء و المؤخر في صيغة الجزاء مقدم في صيغة القسم و الشرط
المنفي في صيغة الجزاء مثبت في صيغة القسم فإنه إذا قال الطلاق يلزمني لا
أفعل كذا فقد حلف بالطلاق أن لا يفعل فالطلاق مقدم و الفعل مؤخر منفي ولو
حلف بصيغة الجزاء لقال إن فعلت كذا فامرأتي طالق فكان تقدم الفعل مثبتا و
تأخر الطلاق منفيا كما أنه في القسم قدم الحكم
و أخر الفعل و بهذه القاعدة تنحل مسائل كثيرة من مسائل الأيمان
فأما صيغة الجزاء فهي جملة فعلية في الأصل فإن أدوات الشرط لا يتصل بها في
الأصل إلا الفعل و أما صيغة القسم فتكون فعلية كقوله أحلف بالله أو تالله
أو و الله و نحو ذلك و تكون اسمية كقوله لعمر الله لأفعلن و الحل علي حرام
لأفعلن
ثم هذا التقسيم ليس من خصائص الأيمان التي بين العبد و بين الله بل غير
ذلك من العقود التي تكون بين الآدميين تارة تكون بصيغة التعليق الذي هو
الشرط و الجزاء كقوله في الجعالة من رد عبدي الآبق فله كذا وقوله في السبق
من سبق فله كذا و تارة بصيغة الجزم و التحقيق إما صيغة خبر كقوله بعت و
زوجت و إما صيغة طلب كقول بعني و اخلعني
المقدمة الثالثة و بها يظهر مسائل الأيمان و نحوها أن صيغة التعليق التي
تسمى صيغة الشرط و صيغة المجازاة تنقسم إلى ستة أنواع لأن الحالف إما أن
يكون مقصوده وجود الشرط فقط أو وجود الجزاء فقط أو وجودهما و إما أن لا
يقصد وجود واحد منهما بل يكون مقصوده عدم الشرط فقط أو عدم الجزاء فقط أو
عدمهما فالأول بمنزلة كثير من صور الخلع و الكتابة و نذر التبرر و الجعالة
و نحوها فإن الرجل إذا قال لامرأته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق أو فقد
خلعتك أو قال لعبده إن أديت ألفا فأنت حر أو قال إن رددت عبدي الآبق فلك
ألف درهم أو قال إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فعلي عتق كذا أو
الصدقة بكذا فالمعلق قد لا يكون مقصوده إلا أخذ المال و رد العبد و سلامة
النفس و المال و إنما التزم الجزاء على سبيل العوض كالبائع الذي إنما
مقصوده أخذ الثمن و التزم أداء المبيع على سبيل العوض
فهذا الضرب هو شبيه بالمعاوضة في البيع و الإجارة و كذلك إذا كان قد جعل
الطلاق عقوبة لها مثل أن يقول إذا ضربت أمتي فأنت طالق أو إن
خرجت من الدار فأنت طالق فإنه في الخلع عوضها بالتطليق عن المال
لأنها تريد الطلاق وهنا عوضها عن بعضيتها بالطلاق
و أما الثاني فمثل أن يقول لامرأته إذا طهرت فأنت طالق أو يقول لعبده إذا
مت فأنت حر أو إذا جاء رأس الحول فأنت حر أو فمالي صدقة و نحو ذلك من
التعليق الذي هو توقيت محض فهذا الضرب هو بمنزلة المنجز في أن كل واحد
منهما قصد الطلاق و العتاق و إنما أخره إلى الوقت المعين بمنزلة تأجيل
الدين و بمنزلة من يؤخر التطليق من وقت إلى وقت لغرض له في التأخير لا
لعوض ولا لحلف على طلب أو خبر و لهذا قال الفقهاء من أصحابنا و غيرهم إذا
حلف أنه لا يحلف بالطلاق مثل أن يقول والله لا أحلف بطلاقك أو إن حلفت
بطلاقك فعبدي حر أو فأنت طالق وأنه إذا قال إن دخلت أو إن لم تدخلي و نحو
ذلك مما فيه معنى الحض أو المنع فهو حالف ولو كان تعليقا محضا كقوله إذا
طلعت الشمس فأنت طالق أو أنت طالق إن طلعت الشمس فاختلفوا فيه قال أصحاب
الشافعي ليس بحالف وقال أصحاب أبي حنيفة و القاضي في الجامع هو حالف
و أما الثالث وهو أن يكون مقصوده وجودهما فمثل الذي قد آذته المرأة حتى
أحب طلاقها و استرجاع الفدية منها فيقول إن أبرأتيني من صداقك أو من نفقتك
فأنت طالق وهو يريد كلا منهما
و أما الرابع وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط لكنه إذا وجد لم يكره الجزاء
بل يحبه أو لا يحبه ولا يكرهه فمثل أن يقول لامرأته إن زنيت فأنت طالق أو
إن ضربت أمي فأنت طالق و نحو ذلك من التعليق الذي يقصد فيه عدم الشرط و
يقصد وجود الجزاء عند وجوده بحيث إذا زنت أو إذا ضربت أمه يجب أن يفارقها
لأنها لا تصلح له فهذا فيه معنى اليمين و فيه معنى التوقيت فإنه منعها من
الفعل و قصد إيقاع الطلاق عنده كما قصد
إيقاعه عند أخذ العوض منها أو عند طهرها أو عند طلوع الهلال
و أما الخامس وهو أن يكون مقصوده عدم الجزاء و تعلقه بالشرط لئلا يوجد و
ليس له غرض في عدم الشرط فهذا قليل كمن يقول إن أصبت مائة رمية أعطيتك كذا
و أما السادس وهو أن يكون مقصودهما عدم الشرط و الجزاء و إنما تعلق الجزاء
بالشرط ليمتنع وجودهما فهو مثل نذر اللجاج و الغضب و مثل الحلف بالطلاق و
العتاق على حض أو منع أو تصديق أو تكذيب مثل أن يقال له تصدق على فلان أو
أصلح بين فلان و فلان أو حج في هذه السنة فيقول إن تصدقت عليه فعليه صيام
كذا أو فامرأته طالق أو فعبيده أحرار أو يقول إن لم أفعل كذا و كذا فعلي
نذر كذا أو امرأتي طالق أو عبدي حر أو يحلف على غيره ممن يقصد منعه كعبده
و نسيبه و صديقه ممن يحضه على طاعته فيقول له إن فعلت أو إن لم تفعلي فعلي
كذا أو فامرأتي طالق أو فعبيدي أحرار و نحو ذلك
فهذا نذر اللجاج و الغضب و ما أشبهه من الحلف بالطلاق و العتاق يخالف في
المعنى نذر التبرر و التقرب و ما أشبهه من الخلع و الكتابة فإن الذي يقول
إن سلمني الله أو سلم مالي من كذا أو إن أعطاني الله كذا فعلي أن أتصدق أو
أصوم أو أحج قصده حصول الشرط الذي هو الغنيمة أو السلامة و قصد أن يشكر
الله على ذلك بما نذره و كذلك المخالع و المكاتب قصده حصول العوض و بذل
الطلاق و العتاق عوضا عن ذلك
و أما النذر في اللجاج و الغضب فكما إذا قيل له افعل كذا فامتنع من فعله
ثم قال إن فعلته فعلي الحج أو الصيام فهنا مقصوده أن لا يكون الشرط ثم إنه
لقوة امتناعه ألزم نفسه إن فعله بهذه الأمور الثقيلة عليه ليكون لزومها له
إذا فعل مانعا له من الفعل و كذلك إذا قال إن فعلته فامرأتي طالق أو
فعبيدي أحرار إنما مقصوده الامتناع و التزم بتقدير الفعل ما هو
شديد عليه من فراق أهله و ذهاب ماله ليس غرض هذا أن يتقرب إلى
الله بعتق أو صدقة ولا أن يفارق امرأته و لهذا سمى العلماء هذا نذر اللجاج
و الغضب مأخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه في الصحيحين
من حديث أبي هريرة ( والله لا يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله
من أن يعطي الكفارة التي فرض الله عليه )
فصورة هذا النذر صورة نذر التبرر في اللفظ و معناه شديد المباينة لمعناه
ومن هذا نشأت الشبهة التي سنذكرها في هذا الباب إن شاء الله تعالى على
طائفة من العلماء و بهذا يتبين فقه الصحابة الذين نظروا إلى معاني الألفاظ
لا إلى صورها
إذا تبينت هذه الأنواع الداخلة في قسم التعليق فقد علمت أن بعضها معناه
معنى اليمين بصيغة القسم و بعضها ليس معناه معنى اليمين بصيغة القسم فمتى
كان الشرط المقصود حضا على فعل أو منعا منه أو تصديقا لخبر أو تكذيبا كان
الشرط مقصود العدم هو و جزاؤه كنذر اللجاج والغضب و الحلف بالطلاق على وجه
اللجاج و الغضب
القاعدة الأولى أن الحالف بالله سبحانه قد بين الله حكمه بالكتاب و السنة
و الإجماع
أما الكتاب فقال تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم
بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم } و قال { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
} و قال { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو
تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم
واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون }
و أما السنة ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال له ( يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن
أعطيتها عن مسألة وكلت إليها و إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها و إذا
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير و كفر عن يمينك )
فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكم الأمانة الذي هو الإمارة و حكم
العهد الذي هو اليمين و كانوا في أول الإسلام لا مخرج لهم من اليمين قبل
أن تشرع الكفارة و لهذا قالت عائشة كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل
الله كفارة اليمين و ذلك لأن اليمين بالله عقد بالله فيجب الوفاء به كما
يجب في سائر العقود و أشد لأن قوله أحلف بالله و أقسم بالله و أولي الله و
نحو ذلك في معنى قوله أعقد بالله لهذا عدي بحرف الإلصاق الذي يستعمل في
الربط و العقد فينعقد المحلوف عليه بالله كما تنعقد إحدى اليدين بالأخرى
في المعاقدة و لهذا سماه الله سبحانه عقدا في قوله { ولكن يؤاخذكم بما
عقدتم الأيمان } فإذا كان قد عقدها بالله فإن الحنث فيها نقض لعهد الله و
ميثاقه لولا ما فرضه الله من التحلة و لهذا سمي حلها حنثا و الحنث هو
الإثم في الأصل فالحنث فيها سبب للإثم لولا الكفارة الماحية و إنما
الكفارة منعته أن يوجب إثما
و نظير الرخصة في كفارة اليمين بعد عقدها الرخصة أيضا في كفارة الظهار بعد
أن كان الظهار في الجاهلية و أول الإسلام طلاقا و كذلك الإيلاء كان عندهم
طلاقا فإن هذا جار على قاعدة وجوب الوفاء بمقتضى اليمين فإن الإيلاء إذا
أوجب الوفاء بمقتضاه من ترك الوطء صار الوطء محرما و تحريم الوطء تحريما
مطلقا مستلزم لزوال الملك الذي هو الطلاق و كذلك الظهار إذا أوجب التحريم
فالتحريم مستلزم لزوال الملك فإن الزوجة لا تكون محرمة على الإطلاق و لهذا
قال سبحانه وتعالى { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات
أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم }
و التحلة مصدر حللت الشيء تحليلا و تحلة كما يقال كرمته تكريما و
تكرمة وهذا المصدر يسمى به المحلل نفسه الذي هو الكفارة فإن أريد المصدر
فالمعنى فرض الله لكم تحليل اليمين وهو حلها الذي هو خلاف العقد أو الحل و
لهذا استدل من استدل من أصحابنا و غيرهم كأبي بكر بن عبد العزيز بهذه
الآية على التكفير قبل الحنث لأن التحلة لا تكون بعد الحنث فإنه بالحنث
تنحل اليمين و إنما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتتحلل اليمين و إنما
هي بعد الحنث كفارة لأنها كفرت ما في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله
فإذا تبين أن ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه الأمة
بالكفارة التي جعلها بدلا من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الأخبار التي
نبه عليها بقوله تعالى { ويضع عنهم إصرهم } فالأفعال ثلاثة إما طاعة و إما
معصية و إما مباح فإذا حلف ليفعلنه مباحا أو ليتركنه فهنا الكفارة مشروعة
بالإجماع و كذلك إذا كان المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب وهو المذكور
في قوله تعالى { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا
بين الناس والله سميع عليم }
و أما إن كان المحلوف عليه ترك واجب أو فعل محرم فهنا لا يجوز الوفاء به
بالاتفاق بل يجب التكفير عند عامة العلماء
و أما قبل أن تشرع الكفارة فكان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوفاء
بيمينه ولا كفارة له ترفع عنه مقتضى الحنث بل يكون عاصيا معصية لا كفارة
فيها سواء وفى أم لم يف كما لو نذر معصية عند من لم يجعل في نذره كفارة و
إن كان المحلوف عليه فعل طاعة غير واجبة
فصل
فأما الحالف بالنذر الذي هو نذر اللجاج و الغضب مثل أن يقول إذا فعلتكذلك فعلى الحج أو فمالي صدقة أو فعلى صيام يريد بذلك أن يمنع
نفسه عن الفعل أو أن يقول إن لم أفعل كذل فعلى الحج ونحوه فمذهب أهل العلم
من أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة أنه يجزيه كفارة يمين وهو قول فقهاء
الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم وهذا هو إحدى الروايتين عن
أبي حنيفة وهو الرواية المتأخرة عنه
ثم اختلف هؤلاء فأكثرهم قالوا هو مخير بين الوفاء بما نذره وبين كفارة
يمين وهذا قول الشافعي والمشهور عن أحمد ومنهم من قال بل عليه الكفارة
عينا كما يلزمه ذلك في اليمين بالله وهو الرواية الأخرى عن أحمد وقول بعض
أصحاب الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة في الرواية الأخرى وطائفة بل يجب
الوفاء بهذا النذر
وقد ذكروا أن الشافعي سئل عن هذه المسألة بمصر فأفتى فيها بالكفارة فقال
له السائل يا أبا عبد الله هذا قولك فقال قول من هو خير منى عطاء ابن أبي
رباح وذكروا أن عبد الرحمن بن القاسم حث ابنه في هذه اليمين فأفتاه بكفارة
يمين بقول الليث بن سعد وقال إن عدت أفتيك بقول مالك وهو الوفاء به ولهذا
يفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليمين على عمومات الوفاء بالنذر كقوله صلى
الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه لأنه حكم جائز معلق بشرط فوجب
عند ثبوت شرطه كسائر الأحكام والأول هو الصحيح والدليل عليه مع ما سنذكره
إن شاء الله من دلالة الكتاب والسنة ما اعتمده الإمام أحمد وغيره
قال أبو بكر الأثرم في مسائله سألت أبا عبد الله عن رجل قال ماله في رتاج
الكعبة قال كفارة يمين واحتج بحديث عائشة قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن
الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو الصدقة بالملك أو نحو هذه اليمين فقال
إذا حنث فكفارة يمين إلا أنى لا أحمله على الحنث ما لم يحنث قال له لا
يفعل قيل لأبي عبد الله فإذا حنث كفر قال نعم قيل له
أليس كفارة يمين قال نعم قال وسمعت أبا عبد الله يقول في حديث
ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا كل مملوك لها حر فأفتيت بكفارة يمين
فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جاريته وأيمان
فقال أما الجارية فعتق قال الأثرم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا حسن عبد الله
بن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت من قال مالي في رتاج الكعبة وكل مالي
فهو هدى وكل مالي في المساكين فليكفر عن يمينه
وقال حدثنا عارم بن الفضل حدثنا معتمر بن سلميان قال قال أبي حدثنا بكر بن
عبد الله أخبرني أبو رافع قال قالت مولاتى ليلى بنت العجماء كل مملوك لها
محرر وكل مال لها هدى هى يهودية وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك أو تفرق
بينك وبين امرأتك قال فأتيت زينب بنت أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة
بالمدينة فقيهة ذكرت زينب قال فأتيتها فجاءت معي إليها فقالت في البيت
هاروت وماروت قالت يا زينب جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها محرر
وكل مال لها هدى وهى يهودية وهى نصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلى بين
الرجل وامرأته فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتها فقالت يا أم
المؤمنين جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك محرر وكل مال لها هدى وهى
يهودية وهى نصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلى بين الرجل وبين امرأته قال
فأتيت عبد الله بن عمر فجاء معي إليها فقام على الباب فسلم فقالت بأبي أنت
وبأبي أبوك فقال أمن حجارة أنت أم من حديد أنت أم من أى شئ أنت أفتتك زينب
وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي فتياهما قالت يا أبا عبد الرحمن جعلني الله
فداءك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهى يهودية وهى نصرانية
فقال يهودية ونصرانية كفري عن يمينك وخلى بين الرجل وبين امرأته
قال الأثرم حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا عمران عن قتادة عن
زرارة ابن أوفى أن امرأة سألت ابن عباس أن امرأة جعلت بردها عليها هديا إن
لبسته فقال ابن عباس أفي غضب أم في رضى قالت في غضب قال إن الله تعالى لا
يتقرب إليه بالغضب لتكفر عن يمينها وقال حدثني ابن الطباع حدثنا أبو بكر
بن عياش عن العلاء بن المسيب عن يعلى بن نعمان عن عكرمة عن ابن عباس رضى
الله عنهما سئل عن الرجل جعل ماله في المساكين فقال أمسك عليك مالك وأنفقه
على عيالك واقض به دينك وكفر عن يمينك وروى الأثرم عن أحمد قال حدثنا عبد
الرزاق أنبأنا ابن جريج قال سئل عطاء عن رجل قال على ألف بدنه قال يمين
وعن رجل قال على ألف حجة قال يمين وعن رجل قال مالي هدى قال يمين وعن رجل
قال مالي في المساكين قال يمين وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن
قتادة عن الحسن وجابر بن زيد في الرجل يقول إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم
بحجة قالا ليس الإحرام إلا على من نوى الحج يمين يكفرها وقال أحمد حدثنا
عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال يمين يكفرها وقال حرب
الكرمانى حدثنا المسيب بن واضح حدثنا يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن عطاء
بن أبي رباح قال سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله الحرام
قال إنما المشي على من نواه فأما من حلف في الغضب فعليه كفارة يمين
وأيضا فإن الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه وهذا الحالف ليس
مقصوده قربة الله وإنما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه وهذا معنى
اليمين فإن الحالف يقصد الحض على فعل شئ أو المنع منه ثم إذا علق ذلك
الفعل بالله تعالى أجزأته الكفارة فلأن تجزيه إذا علق به وجوب عبادة أو
تحريم مباح بطريق الأولى لأنه إذا علقه بالله ثم حنث كان موجب
حنثه أنه قد هتك أيمانه بالله حيث لم يف بعهده وإذا علق به وجوب
فعل أو تحريمه فإنما يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل محرم ومعلوم أن الحنث
الذي موجبه خلل في التوحيد أعظم مما موجبه معصية من المعاصي فإذا كان الله
قد شرع الكفارة لإصلاح ما اقتضي الحنث فساده في التوحيد ونحو ذلك وجبره
فلأن يشرع لإصلاح ما اقتضى الحنث فساده في الطاعة أولى وأحرى
وأيضا فإنا نقول إن موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق والنذر نوع من
اليمين وكل نذر فهو يمين فقول الناذر لله على أن أفعل بمنزلة قوله أحلف
بالله لأفعلن موجب هذين القولين التزام الفعل معلقا بالله
والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم النذر حلفة فقوله إن فعلت
كذا فعلى الحج لله بمنزلة قوله إن فعلت كذا فوالله لأحجن
وطرد هذا انه اذا حلف ليفعلن برا لزمه فعله ولم يكن له ان يكفر فإن حلفه
ليفعلنه نذر لفعله
وكذلك طرد هذا أنه إذا نذر ليفعلن معصية أو مباحا فقد حلف على فعلها
بمنزلة ما لو قال والله لأفعلن كذا ولو حلف بالله ليفعلن معصية أو مباحا
لزمته كفارة يمين وكذلك لو قال على لله أن أفعل كذا
ومن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يفرق بين البابين
فصل
فأما اليمين بالطلاق أو العتاق في اللجاج و الغضب فمثل أن يقصد بها حضا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا مثل قوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا فعلت كذا أو إن فعلت كذا فعبيدي أحرار أو إن لم أفعله فعبيدي أحرار فمنقال من الفقهاء المتقدمين إن نذر اللجاج و الغضب يجب فيه الوفاء
فإنه يقول هنا يقع الطلاق و العتاق أيضا و أما الجمهور الذين قالوا في نذر
اللجاج والغضب تجزيه الكفارة فاختلفوا هنا مع أنه لم يبلغني عن الصحابة في
الحلف بالطلاق كلام و إنما بلغنا الكلام فيها عن التابعين ومن بعدهم لأن
اليمين به محدثة لم تكن تعرف في عصرهم و لكن بلغنا عن الصحابة الكلام في
الحلف بالعتق كما سنذكره إن شاء الله
فاختلف التابعون ومن بعدهم في اليمين بالطلاق و العتاق فمنهم من فرق بينه
و بين اليمين بالنذر وقالوا إنه يقع الطلاق و العتاق بالحنث ولا تجزيه
الكفارة بخلاف اليمين بالنذر هذا رواية عوف عن الحسن وهو قول الشافعي و
أحمد في الصريح المنصوص عنه و إسحاق بن راهويه و أبي عبيد و غيرهم
فروى حرب الكرماني عن معتمر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال
كل يمين و إن عظمت ولو حلف بالحج و العمرة و إن جعل ماله في
المساكين ما لم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم حلف أو عتق غلام في ملكه يوم
حلف فإنما هي يمين وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد بن حنبل عن
الرجل يقول لابنه إن كلمتك فامرأتي طالق و عبدي حر فقال لا يقوم هذا مقام
اليمين و يلزمه ذلك في الغضب و الرضا و قال سليمان بن داود يلزمه الحنث في
الطلاق و العتاق وبه قال أبو خيثمة قال إسماعيل حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا
عبد الرزاق عن معمر بن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن حاضر الحميري أن امرأة
حلفت بمالها في سبيل الله أو في المساكين و جاريتها حرة إن لم تفعل كذا و
كذا فسألت ابن عمر و ابن عباس فقالا أما الجارية فتعتق و أما قولها في
المال فإنها تزكي المال قال أبو إسحاق إبراهيمم الجوزجاني الطلاق و العتق
لا يحلان في هذا محل الأيمان ولو كان المجزئ فيها مجزئا في الأيمان لوقع
على الحالف بها إذا حنث كفارة وهذا مما لا يختلف الناس فيه أن لا كفارة
فيها
قلت أخبر أبو إسحاق بما بلغه من العلم في ذلك فإن أكثر مفتي الناس في ذلك
الزمان من أهل المدينة و أهل العراق أصحاب أبي حنيفة و مالك كانوا لا
يفتون في نذر اللجاج و الغضب إلا بوجوب الوفاء لا بالكفارة و إن كان أكثر
التابعين مذهبهم فيها الكفارة حتى إن الشافعي لما أفتى بمصر بجواز الكفارة
كان غريبا بين أصحابه المالكية وقال له السائل يا أبا عبد الله هذا قولك
فقال قول من هو خير مني قول عطاء بن أبي رباح فلما أفتى فقهاء الحديث
كالشافعي و أحمد و إسحاق و أبي عبيد و سليمان بن داود و ابن أبي شيبة و
علي المديني و نحوهم في الحلف بالنذر بالكفارة و فرق من فرق بين ذلك و بين
الطلاق و العتاق لما سنذكره صار الذي يعرف قول هؤلاء و قول أولئك لا يعلم
خلافا في الطلاق و العتاق و إلا فسنذكر الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى
عن الصحابة
و التابعين ومن بعدهم وقد اعتذر أحمد عما ذكرناه عن الصحابة في
كفارة العتق بعذرين
أحدهما انفراد سليمان التيمي بذلك
و الثاني معارضته بما رواه عن ابن عمر و ابن عباس أن العتق يقع من غير
تكفير وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم
المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد فقال المروزي قال أبو عبد الله إذا قال كل
مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث لأن الطلاق و العتق ليس فيهما كفارة و قال
ليس يقول كل مملوك لها حر في حديث ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع أنها
سألت ابن عمر و حفصة و زينب و ذكرت العتق فأمروها بالكفارة إلا التيمي و
أما حميد و غيره فلم يذكروا العتق قال سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع
قصة حلف مولاته ليفارقن امرأته و أنها سألت ابن عمر و حفصة فأمروها بكفارة
يمين قلت فيها شيء قال نعم أذهب إلى أن فيه كفارة يمين قال أبو عبد الله
ليس يقول فيه كل مملوك إلا التيمي قلت فإذا حلف بعتق مملوكه فحنث قال يعتق
كذا يروي عن ابن عمر و ابن عباس أنهما قالا الجارية تعتق ثم قال ما سمعناه
إلا من عبد الرزاق عن معمر قلت فإبش إسناده قال معمر عن إسماعيل عن عثمان
بن حاضر عن ابن عمر و ابن عباس وقال إسماعيل ابن أمية و أيوب ابن موسى
وهما مكيان و قد فرقا بين الحلف بالطلاق و العتق و الحلف بالنذر لأنهما لا
يكفران و اتبع ما بلغه في ذلك عن ابن عمر و حفصة و زينب مع انفراد التيمي
بهذه الزيادة وقال صالح ابن أحمد قال أبي و إذا قال جاريتي حرة إن لم أصنع
كذا و كذا قال قال ابن عمر و ابن عباس تعتق و إذا قال كل مالي في المساكين
لم يدخل فيه جاريته
فإن هذا لا يشبه هذا ألا ترى أن عمر فرق بينهما العتق و الطلاق
لا يكفران و أصحاب أبي حنيفة يقولون إذا قال الرجل مالي في المساكين إنه
يتصدق به على المساكين و إذا قال مالي على فلان صدقة و فرقوا بين قوله إن
فعلت كذا فمالي صدقة أو فعلي الحج و بين قوله فامرأته طالق أو فعبدي حر
بأنه هناك وجب القول وجوب الصدقة و الحج لا وجود الصدقة و الحج
فإذا اقتضى الشرط وجوب ذلك كانت الكفارة بدلا عن هذا الواجب كما تكون بدلا
عن غيره من الواجبات كما كانت في أول الإسلام بدلا عن الصوم الواجب و
الإطعام بدلا عن الصوم عن العاجز عنه و كما تكون بدلا عن الصوم الواجب في
ذمة الميت فإن الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بأدائه و أداء غيره
و أما العتق و الطلاق فإن موجب الكلام وجودهما فإذا وجد الشرط وجد العتق و
الطلاق و إذا وقعا لم يرتفعا بعد وقوعهما لأنهما لا يقبلان الفسخ بخلاف ما
لو قال إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق فإنه هنا لم يعلق العتق و إنما علق
وجوبه بالشرط فيخير بين فعل هذا الإعتاق الذي أوجبه على نفسه و بين
الكفارة التي هي بدلا عنه ولهذا لو قال إذا مت فعبدي حر عتق بموته من غير
حاجة إلى الإعتاق ولم يكن له فسخ هذا التدبير عند الجمهور إلا قولا
للشافعي و رواية أحمد وفي بيعه الخلاف المشهور ولو وصى بعتقه فقال إذا مت
فأعتقوه كان له الرجوع في ذلك كسائر الوصايا وكان بيعه هنا و إن لم يجز
كبيع المدبر
ذكر أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة في تاريخه أن المهدي لما رأى ما
أجمع عليه رأي أهل بيته من العهد عزم على خلع عيسى و دعاهم إلى البيعة
لموسى فامتنع عيسى من الخلع و زعم أن عليه أيمانا تخرجه من أملاكه و تطلق
نساءه فأحضر له المهدي ابن علاثة و مسلم ابن خالد الزنجي و جماعة من
الفقهاء
فأفتوه بما يخرجه عن يمينه و اعتاض مما يلزمه في يمينه بما ذكره
ولم يزل به إلى أن خلع نفسه و بويع للمهدي و لموسى الهادي بعده
و أما أبو ثور فقال في العتق المعلق على وجه اليمين يجزئه كفارة يمين كنذر
اللجاج و الغضب لأجل ما تقدم من حديث ليلى بنت العجماء التي أفتاها عبد
الله بن عمر و حفصة أم المؤمنين و زينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه
وسلم بكفارة يمين في قولها إن لم أفرق بينك و بين امرأتك فكل مملوك لي
محرر وهذه القصة هي مما اعتمده الفقهاء المستدلون في مسألة نذر اللجاج
والغضب لكن توقف أحمد و أبو عبيد عن العتق فيها لما ذكرته من الفرق و عارض
أحمد ذلك و أما الطلاق فلم يبلغ أبا ثور فيه أثر فتوقف عنه مع أن القياس
عنده مساواته للعتق لكن خاف أن يكون مخالفا للإجماع
و الصواب أن الخلاف في الجميع في الطلاق و غيره كما سنذكره ولو لم ينقل في
الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحابة في الحلف بالعتاق
بكفارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق فإنه إذا كان نذر العتق
الذي هو قربة لما خرج مخرج اليمين أجزأت فيه الكفارة فالحلف بالطلاق الذي
ليس بقربة إما أن تجزئ فيه الكفارة ولا يجب فيه شيء على قول من يقول نذر
غير الطاعة لا شيء فيه و يكون قوله إن فعلت كذا فأنت طالق بمنزلة قوله
فعلي أن أطلقك كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم قوله فعبيدي أحرار
بمنزلة قوله فعلي أن أعتقهم
على أني إلى الساعة لم يبلغني عن أحد من الصحابة كلام في الحلف بالطلاق و
ذاك و الله أعلم لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم و إنما ابتدعه
الناس في زمن التابعين ومن بعدهم فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم فأحد
القولين أنه يقع به كما تقدم و القول الثاني أنه لا يلزمه الوقوع ذكر عبد
الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول الحلف
بالطلاق ليس شيئا قلت أكان يراه يمينا قال لا أدري
فقد أخبر ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يراه موقعا للطلاق و توقف في كونه
يمينا يوجب الكفارة لأنه من باب نذر ما لا قربة فيه وفي كون مثل هذا يمينا
خلاف مشهور وهذا قول أهل الظاهر كداود و أبي محمد بن حزم لكن بناء على أنه
لا يقع طلاق معلق ولا عتق معلق
و اختلفوا في المؤجل وهو بناء على ما تقدم من أن العقود لا يصح منها إلا
ما ورد نص أو إجماع على وجوبه أو جوازه وهو مبني على ثلاث مقدمات يخالفون
فيها
إحداها كون الأصل تحريم العقود
الثانية أنه لا يباح إلا ما كان في معنى النصوص
الثالثة أن الطلاق المؤجل و المعلق لم يندرج في عموم النصوص
و أما المأخذ المتقدم من كون هذا كنذر اللجاج و الغضب و فرقوا بين نذر
التبرر و نذر الغضب فإن هذا الفرق يوجب الفرق بين المعلق الذي يقصد وقوعه
عند الشرط و بين المعلق المحلوف به الذي يقصد عدم وقوعه إلا أن يصح الفرق
المذكور بين كون المعلق هو الوجود أو الوجوب و سنتكلم عليه
وقد ذكرنا أن هذا القول يخرج على أصول أحمد من مواضع ذكرناها و كذلك هو
أيضا لازم لمن قال في نذر اللجاج و الغضب بكفارة كما هو ظاهر مذهب الشافعي
و إحدى الروايتين عن أبي حنيفة التي اختارها أكثر متأخري أصحابه و إحدى
الروايتين عن ابن القاسم التي اختارها كثير من متأخري المالكية فإن
التسوية بين الحلف بالنذر و الحلف بالعتق هو المتوجه و لهذا كان هذا من
أقوى حجج القائلين بوجوب الوفاء في الحلف بالنذر فإنهم قاسوه على الحلف
بالطلاق و العتاق و اعتقده بعض المالكية مجمعا عليه
و أيضا فإذا حلف بصيغة القسم كقوله عبيدي أحرار لأفعلن أو نسائي
طوالق لأفعلن فهو بمنزلة قوله مالي صدقة لأفعلن و علي الحج
لأفعلن
و الذي يوضح التسوية أن الشافعي إنما اعتمد في الطلاق المعلق على فدية
الخلع فقال في البويطي وهو كتاب مصري من أجود كتبه و ذلك أن الفقهاء يسمون
الطلاق المعلق بسبب طلاقا بصفة و يسمون ذلك الشرط صفة و يقولون إذا وجدت
الصفة في زمان البينونة و إذا لم توجد الصفة و نحو ذلك
وهذه التسمية لها وجهان
أحدهما أن هذا الطلاق موصوف بصفة ليس طلاقا مجردا عن صفة فإنه إذا قال أنت
طالق في أول السنة أو إذا ظهرت فقد وصف الطلاق بالزمان الخاص فإن الظرف
صفة للمظروف و كذلك إذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فقد وصفه بعوضه
و الثاني أن نحاة الكوفة يسمون حروف الجر و نحوها حروف الصفات فلما كان
هذا معلقا بالحروف التي قد تسمى حروف الصفات سمي طلاقا بصفة كما لو قال
أنت طالق بألف
و الوجه الأول هو الأصل فإن هذا يعود إليه إذ النحاة إنما سموا حروف الجر
حروف الصفات لأن الجار و المجرور يصير في المعنى صفة لما تعلق به
فإذا كان الشافعي و غيره إنما اعتمدوا في الطلاق الموصوف على طلاق الفدية
المذكور في القرآن و قاسوا كل طلاق بصفة عليه صار هذا كما أن النذر المعلق
بشرط مذكور في قوله { ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن
ولنكونن من الصالحين } و معلوم أن النذر المعلق بشرط هو نذر بصفة وقد
فرقوا بين النذر المقصود شرطه و بين النذر المقصود عدم شرطه الذي خرج مخرج
اليمين فكذلك يفرق بين الطلاق المقصود وصفة كالخلع حيث المقصود فيه العوض
و الطلاق المحلوف به الذي يقصد عدمه
و عدم شرطه فإنه انما يقاس بما في الكتاب و السنة ما أشبهه و
معلوم ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة و بين الصفة المحلوف عليها التي يقصد
عدمها كما فرق بينهما في النذر سواء و الدليل على هذا القول الكتاب و
السنة و الأثر و الاعتبار
أما الكتاب فقوله سبحانه { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي
مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم
وهو العليم الحكيم }
فوجه الدلالة أن الله قال { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } وهذا نص عام
في كل يمين يحلف بها المسلمون أن الله قد فرض لهم تحلتها وقد ذكره سبحانه
بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي صلى الله عليه
وسلم مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى فلو فرض يمين واحدة ليس
له تحلة لكان مخالفة للآية كيف وهذا عام لا يحض منه صورة واحدة لا بنص ولا
بإجماع بل هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظي فإن اليمين معقودة فوجب
منع المكلف من الفعل فشرع التحلة لهذا العقد مناسب لما فيه من التخفيف و
التوسعة وهذا موجود في اليمين بالعتق و الطلاق أكثر منه في غيرهما من
أيمان نذر اللجاج و الغضب فإن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن النفس أو
ليقطعن رحمه أو ليمنعن الواجب عليه من أداء الأمانة و نحوها فإنه يجعل
الطلاق عرضة ليمينه أن يبر و يتقي و يصلح بين الناس أكثر مما يجعل الله
عرضة ليمينه ثم إن وفى بيمينه كان عليه من ضرر الدنيا و الآخرة ما قد أجمع
المسلمون على تحريم الدخول فيه و إن طلق امرأته ففي الطلاق أيضا من ضرر
الدنيا و الدين ما لا خفاء به أما الدين فإنه مكروه باتفاق الأمة مع
استقامة حال الزوجين إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم فكيف إذا كانا في
غاية الاتصال و بينهما من الأولاد و العشرة ما يجعل في طلاقهما في أمر
الدين ضررا عظيما و كذلك ضرر الدنيا كما يشهد به الواقع بحيث لو خير
أحدهما بين
أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار فراق ماله ووطنه على
الطلاق وقد قرن الله فراق الوطء بقتل النفس ولهذا قال أحمد في إحدى
الروايتين متابعة لعطاء إنها إذا أحرمت بالحج فحلف عليها زوجها بالطلاق
أنها لا تحج صارت محصرة وجاز لها التحلل لما عليها في ذلك من الضرر الزائد
على ضرر الإحصار بالعدو أو القريب منه
وهذا ظاهر فيما إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أطلقك أو أعتق عبيدي فإن هذا
في نذر اللجاج والغضب بالاتفاق كما لو قال والله لأطلقنك أو لا أعتقت
عبيدي وإنما الفرق بين وجود العتق ووجوبه هو الذي اعتمده المفرقون وسنتكلم
عليه إن شاء الله
وأيضا فإن الله تعالى قال { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي
مرضات أزواجك والله غفور رحيم } وهى تقتضي أنه ما من تحريم لما أحل الله
إلا والله غفور لفاعله رحيم به وأنه لا علة تقتضي ثبوت ذلك التحريم لأن
قول لا شئ استفهام في معنى النفي والإنكار والتقدير لا سبب لتحريمك ما أحل
الله لك والله غفور رحيم فلو كان الحالف بالنذر والعتاق والطلاق على أنه
لا يفعل شيئا لا رخصة له لكان هنا سبب يقتضي تحريم الحلال وانتفاء موجب
المغفرة والرحمة عن هذا الفاعل
وأيضا قوله سبحانه { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة
أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
} والحجة فيها كالحجة في الأولى وأوفى فإنه قال { لا تحرموا طيبات ما أحل
الله لكم }
وهذا عام يشمل تحريمها بالأيمان من الطلاق وغيرها ثم يبين وجه
المخرج من ذلك بقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما
عقدتم الأيمان فكفارته أى فكفارة تعقيدكم أو عقدكم الأيمان وهذا عام ثم
قال ذلك كفارة أيمانكم إ ذا حلفتم وهذا عام كعموم قوله واحفظوا أيمانكم
ومما يوضح عمومه أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم قوله صلى الله عليه
وسلم ( من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك ) فأدخلوا
فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف بالله وإنما لم يدخل مالك وأحمد
وغيرهما الحلف بالطلاق موافقة لابن عباس لأن إيقاع الطلاق ليس بحلف وإنما
الحلف المنعقد ما تضمن محلوفا به ومحلوفا عليه إما بصيغة القسم وإما بصيغة
الجزاء أو ما كان في معنى ذلك مما سنذكره إن شاء الله
وهذه الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد ومن وافقهم في مسألة نذر اللجاج
والغضب فإنهم احتجوا على التكفير فيه بهذه الآية وجعلوا قوله تعالى { تحلة
أيمانكم } و { كفارة أيمانكم } عاما في اليمين بالله واليمين بالنذر
ومعلوم أن شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في الحج والعتق ونحوهما سواء
فإن قيل المراد بالآية اليمين بالله فقط فإن هذا هو المفهوم من مطلق
اليمين ويجوز أن يكون التعريف بالألف واللام أو الإضافة في قوله { عقدتم
الأيمان } و { تحلة أيمانكم } منصرفا إلى اليمين المعهود عندهم وهى اليمين
بالله وحينئذ فلا يعم اللفظ إلا المعروف عندهم والحلف بالطلاق ونحوه لم
يكن معروفا عندهم ولو كان اللفظ عاما فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين
التي ليست مشروعة اليمين بالمخلوقات فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه
لأنه ليس من اليمين المشروعة لقوله صلى الله عليه وسلم ( من كان حالفا
فليحلف بالله أو فليصمت
وهنا سؤال ممن يقول كل يمين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث
فيقال لفظ اليمين يشمل هذا كله بدليل استعمال النبي صلى الله
عليه وسلم والصحابة والعلماء اسم اليمين في هذا كله كقوله صلى الله عليه
وسلم ( النذر حلفة ) وقول الصحابة لمن حلف بالهدى والعتق كفر يمينك
وكذلك فهمته الصحابة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكره ولإدخال
العلماء لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ( من حلف فقال إن شاء الله فإن
شاء فعل وإن شاء ترك )
ويدل على عمومه في الآية أنه سبحانه قال { لم تحرم ما أحل الله لك } ثم
قال { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } فاقتضى هذا أن نفس تحريم الحلال
يمين كما استدل به ابن عباس وغيره وسبب نزول الآية إما تحريمه العسل وإما
تحريمه مارية القبطية وعلى كل تقدير فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية
وليس يمينا بالله ولهذا أفتى جمهور الصحابة كعمر وعثمان وعبد الله بن
مسعود وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم وغيرهم أن تحريم الحلال يمين مكفرة
إما كفارة كبرى كالظهار وإما كفارة صغرى كاليمين بالله وما زال السلف
يسمون الظهار ونحوه يمينا
وأيضا فإن قوله تعالى { لم تحرم ما أحل الله لك } إما أن يراد به لم تحرمه
بلفظ الحرام وإما لم تحرمه باليمين بالله ونحوها وإما لم تحرمه مطلقا فإن
أريد الأول أو الثالث فقد ثبت تحريمه بغير الحلف بالله يمين فنعم وأن أريد
به تحريمه بالحلف بالله فقد سمى الله الحلف بالله تحريما للحلال ومعلوم أن
اليمين بالله لم توجب الحرمة الشرعية لكن لما أوجبت امتناع الحالف من
الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحريما شرطيا لا شرعيا فكل يمين توجب امتناعه
من الفعل فقد حرمت عليه الفعل فيدخل في عموم قوله { لم تحرم ما أحل الله
لك }
وحينئذ فقوله { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } لا بد أن يعم كل يمين
حرمت الحلال لأن هذا حكم ذلك الفعل فلا يد أن يطابق جميع صوره
لأن تحريم الحلال هو سبب قوله { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } وسبب
الجواب إذا كان عاما كان الجواب عاما لئلا يكون جوابا عن البعض دون البعض
مع قيام السبب المقتضى للتعميم وهكذا التقرير في قوله { يا أيها الذين
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } إلى قوله { ذلك كفارة أيمانكم
إذا حلفتم }
وأيضا فإن الصحابة فهمت العموم وكذلك العلماء عامتهم حملوا الآية على
اليمين بالله وغيرها
وأيضا فنقول سلمنا أن اليمين المذكورة في الآية المراد بها اليمين بالله
وأن ما سوى اليمين بالله لا يلزم بها حكم فمعلوم أن الحلف بصفات الله
سبحانه كالحلف به كما لو قال وعزة الله أو لعمر الله أو والقرآن العظيم
فإنه قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي صلى الله عليه وسلم
والصحابة ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة بها وإن كانت الأستعاذة لا تكون
إلا بالله وصفاته في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أعوذ بوجهك )
و ( أعوذ بكلمات الله التامات ) و ( أعوذ برضاك من سخطك ) ونحو
ذلك وهذا أمر مقرر عند العلماء
وإذا كان كذلك فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو الحلف بصفات الله فإنه
إذا قال إن فعلت كذا فعلى الحج فقد حلف بإيجاب الحج عليه وإيجاب الحج حكم
من أحكام الله وهو من صفاته وكذلك لو قال فعلى تحرير رقبة وإذا قال
فامرأتي طالق وعبدي حر فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه والتحريم
من صفات الله كما أن الإيجاب من صفات الله وقد جعل الله ذلك من آياته في
قوله { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } فجعل حدوده في النكاح والطلاق والخلع
من آياته لكنه إذا حلف بالإيجاب والتحريم فقد عقد اليمين لله كما يعقد
النذر لله فإن قوله على الحج والصوم
عقد لله ولكن إذا كان حالفا فهو لم يقصد العقد لله بل قصد الحلف
به فإذا حنث ولم يف به فقد ترك ما عقده لله كما أنه إذا فعل المحلوف به
فقد ترك ما عقده بالله
يوضح ذلك أنه إذا حلف بالله أو بغير الله مما يعظمه بالحلف فإنما حلف به
ليعقد به المحلوف عليه ويربطه لأنه لعظمته في قلبه إذا ربط به شيئا لم
يحله فإذا حل ما ربطه فقد انقضت عظمته في قلبه وقطع السبب الذي بينه وبينه
كما قال بعضهم اليمين العقد على نفسه لحق من له حق ولهذا إذا كانت اليمين
غموسا كانت من الكبائر الموجبة للنار كما قال سبحانه { إن الذين يشترون
بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة } وقال صلى
الله عليه وسلم في عد الكبائر فيما روى الإمام أحمد في المسند عن أبي
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خمس ليس لهن كفارة الشرك
بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن والفرار يوم الزحف ويمين صابرة يقطع
بها مالا يغير حق )
وذلك لأنه إذا تعمد أن يعقد بالله ما ليس منعقدا به فقد نقض الصلة التي
بينه وبين ربه بمنزلة من أخبر عن الله بما هو منزه عنه أو تبرأ من الله
بخلاف ما إذا حلف على المستقبل فإنه عقد بالله فعلا قاصدا لعقده على وجه
التعظيم لله لكن أباح الله له حل هذا العقد الذي عقده به كما يبيح له ترك
بعض الواجبات لحاجة أو يزيل عنه وجوبها ولهذا قال أكثر أهل العلم إذا قال
هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا فهى يمين بمنزلة قوله والله لأفعلن
لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله فيكون قد ربط الفعل
بإيمانه بالله وهذا هو حقيقة الحلف بالله فربط الفعل بأحكام الله من
الإيجاب أو التحريم أدنى حالا من ربطه بالله
يوضح ذلك أنه إذا عقد اليمين بالله فهو عقد لها بإيمانه بالله وهو ما في
قلبه من إجلال الله وإكرامه الذي هو حق الله ومثله الأعلى في السموات
والأرض كما أنه إذا سبح الله وذكره فهو مسبح له وذاكر له بقدر ما في قلبه
من معرفته وعبادته ولذلك جاء التسبيح تارة لاسم الله كما في قوله { سبح
اسم ربك الأعلى } كما أن الذكر يكون تارة لاسم الله كما في قوله { واذكر
اسم ربك بكرة وأصيلا } وكذلك الذكر مع التسبيح في قوله { يا أيها الذين
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا } فحيث عظم العبد ربه
بتسبيح اسمه أو الحلف به أو الاستعاذة به فهو مسبح له بتوسط المثل الأعلى
الذي في قلبه من معرفته وعبادته وعظمته ومحبته علما وقصدا وإجلالا وإكراما
وحكم الإيمان والكفر إنما يعود إلى ما كسبه قلبه من ذلك كما قال سبحانه {
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم } وكما
قال في موضع آخر { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان }
فلو اعتبر الشارع ما في لفظ القسم من انعقاده بالإيمان وارتباطه به دون
قصد الحلف لكان موجبه أنه إذا حنث يتغير إيمانه بزوال حقيقته كما في قوله
صلى الله عليه وسلم ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) كما أنه إذا
حلف على ذلك يمينا فاجرة كانت من الكبائر إذ قد اشترى بها ثمنا قليلا فلا
خلاق له في الآخرة ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم
لكن الشارع علم أن الحالف بها ليفعلن أو لا يفعل ليس غرضه الاستخفاف بحرمة
اسم الله والتعلق به كغرض الحالف في اليمين الغموس فشرع له الكفارة لأنه
حل هذه العقدة وأسقطها عن لغو اليمين لأنه لم يعقد قلبه شيئا من الخيانة
على إيمانه فلا حاجة إلى الكفارة
وإذا ظهر أن موجب اليمين انعقاد الفعل بهذا الإيمان الذي هو إيمانه بالله
فإذا عدم الفعل كان مقتضاه عدم إيمانه هذا لولا ما شرع الله من
الكفارة كما أن مقتضى قوله إن فعلت كذا وجب على كذا أنه عند الحلف يجب ذلك
الفعل لولا ما شرع من الكفارة
يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف بملة غير الإسلام
كاذبا فهو كما قال ) أخرجاه في الصحيحين فجعل اليمين الغموس في قوله هو
يهودي أو نصراني إن فعل كذا كالغموس في قوله والله ما فعلت كذا إذ هو في
كلا الأمرين قد قطع عهده من الله حيث علق الإيمان بأمر معدوم والكفر بأمر
موجود بخلاف اليمين على المستقبل
وطرد هذا المعنى أن اليمين الغموس إذا كانت في النذر أو الطلاق أو العتاق
وقع المعلق به ولم ترفعه الكفارة كما يقع الكفر بذلك في أحد تولى العلماء
وبهذا يحصل الجواب على قولهم المراد به اليمين المشروعة
وأيضا فقوله { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين
الناس والله سميع عليم } فإن السلف مجمعون أو كالمجمعين على أن معناها لا
تجعلوا الله مانعا لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين الناس
بأن يحلف الرجل أن لا يفعل معروفا مستحبا أو واجبا أو ليفعلن مكروها حراما
او نحوه فإذا قيل له افعل ذلك أو لا تفعل هذا قال قد حلفت بالله فيجعل
الله عرضة ليمينه
فإذا كان الله قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانعا لهم بالحلف به من البر
والتقوى فالحلف بهذه الأيمان إن كان داخلا في عموم الحلف وجب أن لا يكون
مانعا وإن لم يكن داخلا فهو أولى أن لا يكون مانعا من باب التنبيه بالأعلى
على الأدنى فإنه إذا نهى عن أن يكون هو سبحانه عرضة لأيماننا أن نبر ونتقى
فغيره أولى أن نكون منتهين عن جعله عرضة لأيماننا وإذا ثبت أننا منهيون عن
أن نجعل شيئا من الأشياء عرضة لأيماننا أن نبر ونتقى
ونصلح بين الناس فمعلوم أن ذلك إنما هو لما في البر والتقوى
والإصلاح مما يحبه الله ويأمر به
فإذا حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق أو بالعتاق أن لا يبر ولا يتقي ولا يصلح
فهو بين أمرين إن وفى ذلك فقد جعل هذه الأشياء عرضة ليمينه أن يبر ويتقى
ويصلح بين الناس وإن حنث فيها وقع عليه الطلاق ووجب عليه فعل المنذور فقد
يكون خروج أهله وماله عنه أبعد عن البر والتقوى من الأمر المحلوف عليه فإن
أقام على يمينه ترك البر والتقوى وإن خرج عن أهله وماله ترك البر والتقوى
فصارت عرضة ليمينه أن يبر ويتقى فلا يخرج عن ذلك إلا بالكفارة وهذا المعنى
هو الذي دلت عليه السنة
ففي الصحيحين من حديث همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ( والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى
كفارته التي افترض الله عليه ) ورواه البخاري أيضا من حديث عكرمة عن أبي
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من استلج في أهله فهو
أعظم إنما ) فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللجاج باليمين في أهل
الحالف أعظم إثما من التكفير واللجاج هو التمادي في الخصومة ومنه قيل رجل
لجوج إذا تمادى في المخاصمة ولهذا تسمى العلماء هذا نذر اللجاج والغضب
فإنه يلج حتى يعقده ثم يلج في الإمتناع من الحنث فبين النبي صلى الله عليه
وسلم أن اللجاج باليمين أعظم إثما من الكفارة وهذا عام في جميع الأيمان
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة ( إذا حلفت
على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك )
أخرجاه في الصحيحين وفي رواية في الصحيحين فكفر عن يمينك وائت هو الذي خير
وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه
وليفعل الذي هو خير ) وفي رواية ( فليأت الذي هو خير وليكفر
عن يمينه ) وهذا نكرة في سياق الشرط فيعم كل حلف على يمين كائنا ما كان
الحلف فإذا رأى غير اليمين المحلوف عليها خيرا منها وهو أن يكون اليمين
المحلوف عليها تركا لخير فيرى فعله خيرا من تركه أو يكون فعلا شر فيرى
تركه خيرا من فعله فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الذي هو خير
ويكفر عن يمينه
وقوله هنا على يمين هو والله أعلم من باب تسمية المفعول باسم المصدر سمى
الأمر المحلوف عليه يمينا كما سمى المخلوق خلقا والمضروب ضربا والمبيع
بيعا ونحو ذلك
وكذلك أخرجا في الصحيحين عن أبي موسى الأشعرى في قصته وقصة أصحابه لما
جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه فقال ( والله ما أحملكم
وما عندي ما أحملكم عليه ) ثم قال ( إني والله إن شاء الله لا أحلف
على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ) وفي
رواية في الصحيحين ( إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير )
وروى مسلم في صحيحه عن عدى بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي
هو خير ) وفي رواية لمسلم أيضا ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا
منها فليكفرها وليأت الذي هو خير )
وقد رويت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذه الوجوه من
حديث عبد الله بن عمر وعوف بن مالك الجشمي
فهذه نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة أنه أمر ( من حلف على
يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير ) ولم يفرق
بين الحلف بالله أو النذر ونحوه ورواه النسائي عن أبي موسى قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى
غيرها خيرا منها إلا أتيته ) وهذا صريح في أنه قصد تعميم كل يمين في
الأرض وكذلك أصحابه فهموا منه دخول الحلف بالنذر في هذا الكلام
فروى أبو داود في سنته حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا
حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار
كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة فكل
مالي في رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك
وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر
في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك
فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر هذا الذي حلف بصيغة
الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب بأن يكفر عن يمينه وأن لا يفعل ذلك المنذور
واحتج بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يمين عليك ولا
نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك )
ففهم من هذا أن من حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة فإنه لا وفاء عليه
في ذلك النذر وإنما عليه الكفارة كما أفتاه عمر ولولا أن هذا النذر كان
عنده يمينا لم يقل له كفر عن يمينك وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم (
( لا يمين ولا نذر ) لأن اليمين ما قصد بها الحض أو المنع والنذر ما قصد
به التقرب وكلاهما لا يوفى به في المعصية والقطيعة
وفي هذا الحديث دلالة أخرى وهى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا
يمين ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ) يعم جميع ما يسمى
يمينا أو نذرا سواء كانت اليمين بالله أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من
الصدقة أو الصيام أو الحج أو الهدى أو كانت بتحريم الحلال كالظهار والطلاق
والعتاق
و مقصود النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون نهيه عن فعل
المحلوف عليه من المعصية و القطيعة فقط أو يكون مقصوده مع ذلك أنه لا
يلزمه ما في اليمين و النذر من الإيجاب و التحريم
وهذا الثاني هو الظاهر لاستدلال عمر بن الخطاب به فإنه لولا أن الحديث يدل
على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب به على ما أجاب به السائل من
الكفارة دون إخراج المال في كسوة الكعبة و لأن لفظ النبي صلى الله عليه و
سلم يعم ذلك كله
و أيضا فمما يبين دخول الحلف بالنذر و الطلاق و العتاق في اليمين و الحلف
في كلام الله و رسوله ما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ( من حلف على يمين فقال أن شاء الله فلا حنث عليه ) رواه أحمد و
النسائي و ابن ماجة و الترمذي و قال حديث حسن و لفظ أبي داود قال حدثنا
سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال (
( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى ) و رواه أيضا من طريق
عبد الوارث عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (
من حلف فاستثنى فإن شاء رجع و إن شاء ترك غير حنث )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من
حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ) رواه أحمد و الترمذي و ابن ماجة و لفظه
فله ثنياه و النسائي وقال فقد استثنى
ثم عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر و بالطلاق و بالعتاق في هذا الحديث
وقالوا ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة بل كثير من أصحاب أحمد يجعل الحلف
بالطلاق لا خلاف فيه في مذهبه و إنما الخلاف فيما إذا كان بصيغة الجزاء و
إنما الذي لا يدخل عند أكثرهم هو نفس إيقاع الطلاق و العتاق و الفرق بين
إيقاعهما و الحلف بهما ظاهر و سنذكر إن شاء الله قاعدة الاستثناء
فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف بهذه الأشياء في قوله صلى الله عليه وسلم (
من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) فكذلك يدخل في قوله (
( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير و ليكفر عن
يمينه ) فإن كلا اللفظين سواء وهذا واضح لمن تأمله
فإن قوله صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا
حنث عليه ) لفظ العموم فيه مثله في قوله ( من حلف على يمين فرأى غيرها
خيرا منها فليأت الذي هو خير و ليكفر عن يمينه ) و إذا كان لفظ رسول
الله صلى الله عليه وسلم في حكم الاستثناء هو لفظه في حكم الكفارة وجب أن
يكون كل ما ينفع فيه الاستثناء ينفع فيه التكفير وكل ما ينفع فيه التكفير
ينفع فيه الاستثناء كما نص عليه أحمد في غير موضع
ومن قال إن الرسول قصد بقوله ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا
حنث عليه ) جميع الأيمان التي يحلف بها من اليمين بالله و بالنذر و
بالطلاق و بالعتاق و أما قوله ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
إلخ ) إنما قصد به اليمين بالله أو اليمين بالله و النذر فقوله ضعيف فإن
حضور موجب أحد اللفظين بقلب النبي صلى الله عليه وسلم مثل حضور موجب اللفظ
الآخر إذ كلاهما لفظ واحد و الحكم فيهما من جنس واحد وهو رافع اليمين إما
بالاستثناء و إما بالتكفير
وعند هذا فاعلم أن الأمة انقسمت في دخول الطلاق و العتاق في حديث
الاستثناء على ثلاثة أقسام
فقوم قالوا يدخل في ذلك الطلاق و العتاق أنفسهما حتى لو قال أنت طالق إن
شاء الله و أنت حر إن شاء الله دخل ذلك في عموم الحديث وهذا قول أبي حنيفة
و الشافعي وغيرهما
وقوم قالوا لا يدخل في ذلك الطلاق و العتاق لا إيقاعهما ولا الحلف بهما
لا بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم وهذا أشهر القولين في مذهب مالك
و إحدى الروايتين عن أحمد
والقول الثالث أن إيقاع الطلاق و العتاق لا يدخل في ذلك بل يدخل فيه الحلف
بالطلاق و العتاق وهذا الرواية الثانية عن أحمد ومن أصحابه من قال إن كان
الحلف بصيغة القسم دخل في الحديث و نفعته المشيئة رواية واحدة وإن كان
بصيغة الجزاء ففيه روايتان
وهذا القول الثالث هو الصواب المأثور معناه عن أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم و جمهور التابعين فإن ابن عباس و أكثر التابعين كسعيد بن المسيب
و الحسن لم يجعلوا في الطلاق استثناء ولم يجعلوه من الأيمان
ثم قد ذكرنا عن الصحابة و جمهور التابعين أنهم جعلوا الحلف بالصدقة و
الهدى و العتاقة و نحو ذلك يمينا مكفرة وهذا معنى قول أحمد في غير موضع لا
استثناء في الطلاق و العتاق ليسا من الأيمان
وقال أيضا الثنيا في الطلاق لا أقول بها و ذلك أن الطلاق و العتاق حرفان
واقعان
وقال أيضا إنما يكون الاستثناء فيما تكون فيه كفارة و الطلاق و العتاق لا
يكفران وهذا الذي قاله ظاهر
و ذلك أن إيقاع الطلاق و العتاق ليسا يمينا أصلا و إنما هو بمنزلة العفو
عن القصاص و الإبراء من الدين و لهذا لو قال و الله لا أحلف على يمين ثم
إنه أعتق عبيدا له أو طلق امرأته أو أبرأ غريمه من دم أو مال أو عرض فإنه
لا يحنث ما علمت أحدا خالف في ذلك
فمن أدخل إيقاع الطلاق و العتاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من
حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث ) فقد حمل العام ما لا يحتمله
كما أن من أخرج من هذا العام قوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا أفعله إن
شاء الله أو إن فعلته فامرأتي طالق إن شاء الله فقد أخرج من
القول العام ما هو داخل فيه فإن هذا اليمين بالطلاق و العتاق وهما ليسا من
الأيمان فإن الحلف بهما كالحلف بالصدقة و الحج و نحوهما و ذلك معلوم
بالاضطرار عقلا و عرفا و شرعا و لهذا لو قال و الله لا أحلف على يمين أبدا
ثم قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق حنث
وقد تقدم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سموه يمينا و كذلك عامة
المسلمين يسمونه يمينا فمعنى اليمين موجود فيه فإنه إذا قال أحلف بالله
لأفعلن إن شاء الله فإن المشيئة تعود عند الإطلاق إلى الفعل المحلوف عليه
و المعنى إني حالف على هذا الفعل إن شاء الله فعله فإذا لم يفعله لم يكن
قد شاءه فلا يكون ملتزما له و إلا فلو نوى عوده إلى الحلف بأن يقصد أني
حالف إن شاء الله أن أكون حالفا كان معنى هذا معنى الاستثناء في الإنشاءات
كالطلاق و العتاق و على مذهب الجمهور لا ينفعه ذلك و كذلك قوله الطلاق
يلزمني لأفعلن كذا إن شاء الله تعود المشيئة عند الإطلاق إلى الفعل
فالمعنى لأفعلنه إن شاء الله فعله فمتى لم يفعله لم يكن الله قد شاءه فلا
يكون ملتزما للطلاق بخلاف ما لو عنى الطلاق يلزمني إن شاء الله لزومه إياه
فإن هذا بمنزلة قوله أنت طالق إن شاء الله
وقول أحمد إنما يكون الاستثناء فيما فيه الكفارة و الطلاق و العتاق لا
يكفران كلام حسن بليغ لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج حكم
الاستثناء و حكم الكفارة مخرجا واحدا بصيغة واحدة فلا يفرق بين ما جمعه
النبي صلى الله عليه وسلم و لأن الاستثناء إنما يقع لما علق به الفعل فإن
الأحكام التي هي الطلاق و العتاق و نحوهما لا تعلق على مشيئة الله بعد
وجود أسبابها فإنها واجبة بوجود أسبابها فإذا انعقدت أسبابها فقد شاءها
الله و إنما تعلق على المشيئة الحوادث التي قد يشاؤها الله وقد لا يشاؤها
من أفعال العباد و نحوها
و الكفارة إنما شرعت لما يحصل من الحنث في اليمين التي قد يحصل
فيها الموافقة بالبر تارة و المخالفة بالحنث أخرى فوجوب الكفارة بالحنث في
اليمين التي تحتمل الموافقة و المخالفة كارتفاع اليمين بالمشيئة التي
تحتمل التعليق و عدم التعليق فكل من حلف على شيء ليفعله فلم يفعله فإنه إن
علقه بالمشيئة فلا حنث عليه و إن لم يعلقه بالمشيئة لزمته الكفارة
فالاستثناء و التكفير يتعاقبان اليمين إذا لم يحصل فيها الموافقة
فهذا أصل صحيح يدفع ما وقع في هذا الباب من الزيادة أو النقص على ما أوجبه
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم يقال بعد ذلك قول أحمد و غيره الطلاق و العتاق لا يكفران كقوله وقول
غيره لا استثناء فيهما وهذا في إيقاع الطلاق و العتاق أما الحلف بهما فليس
تكفيرا لهما و إنما هو تكفير للحلف بهما كما أنه إذا حلف بالصلاة و الصيام
و الصدقة و الحج و الهدي و نحو ذلك في نذر اللجاج و الغضب فإنه لم يكفر
الصلاة و الصيام و الهدي و الحج و إنما كفر الحلف بهما و إلا فالصلاة لا
كفارة فيها و كذلك هذه العبادات لا كفارة فيها لمن يقدر عليها و كما أنه
إذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أعتق فإن عليه الكفارة بلا خلاف في مذهب أحمد
و موافقيه من القائلين بنذر اللجاج و الغضب و ليس ذلك تكفير للعتق و إنما
هو تكفير للحلف به
فلازم قول أحمد هذا أنه إذا جعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء كان الحلف
بهما تصح فيه الكفارة و هذا موجب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
قدمناه
و أما من لم يجعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء كأحد القولين في مذهب مالك
و إحدى الروايتين عن أحمد فهو قول مرجوح
و نحن في هذا المقام إنما نتكلم بتقدير تسليمه و سنتكلم إن شاء الله في
مسألة الاستثناء على حدة
و إذا قال أحمد أو غيره من العلماء إن الحلف بالطلاق و العتاق لا كفارة
فيه لأنه لا استثناء فيه لزم من هذا القول أنه لا استثناء في الحلف بهما و
أما من فرق من أصحاب أحمد فقال يصح في الحلف بهما الاستثناء ولا يصح فيه
الكفارة فهذا الفرق ما أعلمه منصوصا عليه عن أحمد و لكنهم معذورون فيه من
قوله حيث لم يجدوه نص في تكفير الحلف بهما على روايتين
لكن هذا القول لازم على إحدى الروايتين عنه التي ينصرونها ومن سوى
الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن للزومها ولو تفطن لكان إما أن
يلتزمها أولا يلتزمها بل يرجع عن الملزوم أو لا يرجع عنه و يعتقد أنها غير
لوازم
و الفقهاء من أصحابنا و غيرهم إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله و قياسه
فإما أن لا يكون نص على ذلك اللازم لا بنفي ولا إثبات أو نص على نفيه و
إذا نص على نفيه فإما أن يكون نص على نفي لزومه أو لم ينص فإن كان قد نص
على نفي ذلك اللازم و خرجوا عليه خلاف المنصوص عنه في تلك المسألة مثل أن
ينص في مسألتين متشابهتين على قولين مختلفين أو يعلل مسألة بعلة ينقضها في
موضع آخر كما علل أحمد هنا عدم التكفير بعدم الاستثناء وعنه في الاستثناء
روايتان فهذا مبني على تخريج مالم يتكلم بنفي ولا إثبات هل يسمى ذلك مذهبا
له أو لا يسمى
و لأصحابنا فيه خلاف مشهور فالأثرم و الخرقي و غيرهما يجعلونه مذهبا له و
الخلال و صاحبه و غيرهما لا يجعلونه مذهبا له
و التحقيق أنه قياس قوله فليس بمنزلة المذهب المنصوص عنه ولا هو أيضا
بمنزلة ما ليس بلازم قوله بل هو منزلة بين المنزلتين هذا حيث أمكن أن لا
يلتزمه
و أيضا فإن الله شرع الطلاق مبيحا له أو آمرا به و ملزما له إذا أوقعه
صاحبه و كذلك العتق و كذلك النذر
و هذه العقود من النذر و الطلاق و العتاق تقتضي وجوب أشياء على العبد أو
تحريم أشياء عليه و الوجوب و التحريم إنما يلزم العبد إذ قصده أو قصد سببه
فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شئ بالاتفاق ولو تكلم
بهذه الكلمات مكرها لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهور كما دلت عليه السنة
وآثار الصحابة لأن مقصوده إنما هو دفع المكروه عنه لم يقصد حكمها ولا قصد
التكلم بها ابتداء فكذلك الحالف إذا قال إن لم أفعل كذا فعلى الحج أو
الطلاق ليس قصده التزام حج ولا طلاق ولا تكلم بما يوجبه ابتداء وإنما قصده
الحض على ذلك الفعل أو منع نفسه منه كما أن قصد المكره دفع المكروه عنه ثم
قال على طريق المبالغة في الحض والمنع إن فعلت كذا فهذا لى لازم أو هذا
على حرام لشدة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم علق ذلك به فقصده منعهما
جميعا لا ثبوت أحدهما ولا ثبوت سببه وإذا لم يكن قاصدا للحكم ولا لسببه
وإنما قصده عدم الحكم لم يجب أن يلزمه الحكم
وأيضا فإن اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة لم يبلغني أنه كان يحلف به
على عهد قدماء الصحابة ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج
ابن يوسف وهي تشتمل على اليمين بالله و صدقة المال و الطلاق و العتاق و
إني لم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق و إنما
الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم
ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة و انتشرت انتشارا عظيما ثم لما اعتقد من
اعتقد أن الطلاق يقع بها لا محالة صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال على
الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل و نشأ عن ذلك خمسة
أنواع من المفاسد و الحيل في الأيمان حتى اتخذوا آيات الله هزوا
وذلك أنهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لا بد لهم من فعلها إما شرعا
و إما طبعا و غالب ما يحلفون بذلك في حال اللجاج و الغضب ثم فراق
الأهل فيه من الضرر في الدين و الدنيا ما يزيد على كثير من أغلال اليهود و
قد قيل إن الله إنما حرم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوج غيره لئلا يتسارع
الناس إلى الطلاق لما فيه من المفسدة فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور
اللازمة أو الممنوعة وهم محتاجون إلى فعل تلك الأمور أو تركها مع عدم فراق
الأهل فقد قدحت الأفكار لهم أربعة أنواع من الحيل أخذت عن الكوفيين و
غيرهم
الحيلة الأولى في المحلوف عليه فيتؤول لهم خلاف ما قصدوه و خلاف ما يدل
على الكلام في عرف الناس و عاداتهم وهذا هو الذي وضعه بعض المتكلمين في
الفقه و سموه باب المعاياة و سموه باب الحيل في الأيمان و أكثره مما يعلم
بالاضطرار من الدين أنه لا يسوغ في الدين و لا يجوز حمل كلام الحالف عليه
و لهذا كان الأئمة كأحمد و غيره يشددون النكير على من يحتال في هذه
الأيمان
الحيلة الثانية إذا تعذر الاحتيال في الكلام المحلوف عليه احتالوا للفعل
المحلوف عليه بأن يأمروه بمخالعة امرأته ليفعل المحلوف عليه في زمن
البينونة و هذه الحيلة أحدث من التي قبلها و أظنها حدثت في حدود المائة
الثالثة فإن عامة الحيل إنما نشأت عن بعض أهل الكوفة و حيلة الخلع لا تمشي
على أصلهم لأنهم يقولون إذا فعل المحلوف عليه في العدة وقع عليه به الطلاق
لأن المعتدة من فرقة ثانية يلحقها الطلاق عندهم فيحتاج المحتال بهذه
الحيلة إلى أن يتربص حتى تنقضي العدة ثم يفعل المحلوف عليه و هذا فيه ضرر
عليه من جهة طول المدة فصار يفتي بها بعض أصحاب الشافعي و ربما ركبوا معها
أحد قوليه الموافق لأشهر الروايتين عن أحمد من أن الخلع فسخ و ليس بطلاق
فيصيير الخالع كلما أراد الحنث خلع زوجته و فعل المحلوف عليه ثم تزوجها
فإما أن يفتوه بنقص عدد الطلاق أو يفتوه بعدمه
و هذا الخلع الذي هو خلع الأيمان هو شبيه بنكاح المحلل سواء فإن ذلك
عقد عقدا لم يقصده و إنما قصد إزالته و هذا فسخ فسخا لم يقصده و
إنما قصد إزالته وهذه حيلة محدثة باردة قد صنف أبو عبد الله بن بطة جزءا
في إبطالها و ذكر عن السلف في ذلك من الآثار ما قد ذكرت بعضه في غير هذا
الموضع
الحيلة الثالثة إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه احتالوا في المحلوف به
فيبطلوه بالبحث عن شروطه فصار قوم من المتأخرين من أصحاب الشافعي يبحثون
عن صفة عقد النكاح لعله اشتمل على أمر يكون به فاسدا ليرتبوا على ذلك أن
الطلاق في النكاح الفاسد لا يقع و مذهب الشافعي في أحد قوليه و أحمد في
إحدى روايتيه أن الولي الفاسق لا يصح نكاحه و الفسوق غالب على كثير من
الناس فينفق سوق هذه المسألة بسبب الاحتيال لرفع يمين الطلاق حتى رأيت من
صنف في هذه المسألة مصنفا مقصوده به الاحتيال لرفع يمين الطلاق ثم تجد
هؤلاء الذين يحتالون بهذه الحيلة إنما ينظرون في صفة عقد النكاح و كون
ولاية الفاسق لا تصح عند إيقاع الطلاق الذي قد ذهب كثير من أهل العلم أو
أكثرهم إلى أنه يقع في الفاسد في الجملة و أما عند الوطء و الاستمتاع الذي
أجمع المسلمون على أنه لا يباح بالنكاح الفاسد فلا ينظرون في ذلك و كذلك
لا ينظرون في ذلك عند الميراث و غيره من أحكام النكاح الصحيح بل إنما
ينظرون إليه فقط عند وقوع الطلاق خاصة وهو نوع من اتخاذ آيات الله هزوا و
من المكر في آيات الله و إنما أوجبه الحلف بالطلاق و الضرورة إلى عدم
وقوعه
الحيلة الرابعة السريجية في إفساد المحلوف به أيضا لكن لوجود مانع لا
لفوات شرط فإن أبا العباس بن سريج و طائفة بعده اعتقدوا أنه إذ 1 قال
لامرأته إذا وقع عليك طلاقي أو طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا أنه لا يقع بعد
ذلك عليها طلاق أبدا لأنه إذا وقع المنجز لزم وقوع المعلق فإذا وقع المعلق
امتنع وقوع المنجز فيفضي وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يقع و أما عامة فقهاء
الإسلام من جميع الطوائف فأنكروا ذلك بل رأوه من الزلات التي يعلم
بالاضطرار كونها
ليست من دين الإسلام حيث قد علم بالضرورة من دين محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن الطلاق أمر مشروع في كل نكاح و أنه ما من نكاح إلا
و يمكن فيه الطلاق
و سبب الغلط أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام فقالوا إذا وقع المنجز وقع
المعلق و هذا الكلام ليس بصحيح فإنه مستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ووقوع
طلقة مسبوقه بثلاث ممتنع في الشريعة و الكلام المشتمل على ذلك باطل و إذا
كان باطلا لم يلزم من وقوع المنجز وقوع المعلق لأنه إنما يلزم إذا كان
التعليق صحيحا
ثم اختلفوا هل يقع من المعلق تمام الثلاث أن يبطل التعليق ولا يقع إلا
المنجز على قولين في مذهب الشافعي و أحمد و غيرهما
و ما أدري هل استحدث ابن سريج هذه المسألة للاحتيال على رفع الطلاق أم
قالها طردا لقياس اعتقد صحته و احتال بها من بعده لكني رأيت مصنفا لبعض
المتأخرين بعد المائة الخامسة صنفه في هذه المسألة و مقصوده بها الاحتيال
على عدم وقوع الطلاق و لهذا صاغوها بقولهم إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق
قبله ثلاثا لأنه لو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثلاثا لم تنفعه هذه الصيغة في
الحيلة و إن كان كلاهما في الدور سواء و ذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته
إذا طلقتك فعبدي حر أو فأنت طالق لم يحنث إلا بتطليق ينجزه بعد هذه اليمين
أو يعلقه بعدها على شرط فيوجد فإن كل واحد من المنجز و المعلق الذي وجد
شرطه تطليق أما إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه اليمين بشرط ووجد الشرط بعد
هذه اليمين لم يكن مجرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به تطليقا لأن التطليق لا
بد أن يصدر عن المطلق ووجود الطلاق بصفة يفعلها غيره ليس فعلا منه فأما
إذا قال إذا وقع عليك طلاقي فهذا يعم المنجز و المعلق بعد هذا بشرط و
الواقع بعد هذا بشرط تقدم تعليقه
فصوروا المسألة بصورة قوله إذا وقع عليك طلاقي حتى إذا حلف الرجل بالطلاق
لا يفعل شيئا قالوا له قل إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فيقول
ذلك فيقولون له افعل الآن ما حلفت عليه فإنه لا يقع عليك طلاق
فهذا التسرج المنكر عند عامة أهل الإسلام المعلوم يقينا أنه ليس من
الشريعة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم إنما نفقه في الغالب
ما أحوج كثيرا من الناس إليه من الحلف بالطلاق و إلا فلولا ذلك لم يدخل
فيه أحد لأن العاقل لا يكاد يقصد سد باب الطلاق عليه إلا نادرا
الحيلة الخامسة إذا وقع الطلاق و لم يمكن الاحتيال لا في المحلوف عليه
قولا ولا فعلا ولا في المحلوف به إبطالا ولا منعا احتالوا لإعادة النكاح
بنكاح المحلل الذي دلت عليه السنة و إجماع الصحابة مع دلالة القرآن و
شواهد الأصول على تحريمه و فساده ثم قد تولد من نكاح المحلل من الفساد ما
لا يعلمه إلا الله كما نبهنا على بعضه في كتاب بيان الدليل على إبطال
التحليل و أغلب ما يحوج الناس إلى نكاح المحلل هو الحلف بالطلاق و إلا
فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرجل في الغالب إلا إذا قصده و من قصده لم
يترتب عليه عنده من الندم و الفساد ما يترتب على من اضطر إلى وقوعه لحاجته
إلى الحنث
فهذه المفاسد الخمسة التي هي الاحتيال على نقض الأيمان و إخراجها عن
مفهومها و مقصودها ثم الاحتيال بالخلع و إعادة النكاح ثم الاحتيال بالبحث
عن فساد النكاح ثم الاحتيال بمنع وقوع الطلاق ثم الاحتيال بنكاح المحلل في
هذه الأمور من المكر و الخداع و الاستهزاء بآيات الله و اللعب الذي ينفر
العقلاء عن دين الله و يوجب طعن الكفار فيه كما رأيته في بعض كتب النصارى
و غيرهم و يتبين لكل مؤمن صحيح الفطرة أن دين الإسلام منزه عن هذه
الخزعبلات التي تشبه حيل اليهود و مخاريق الرهبان و أن أكثر ما أوقع
الناس بها و أوجب كثرة إنكار الفقهاء عليها و استخراجهم لها هو
حلف الناس بالطلاق و اعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لا محالة حتى لقد فرع
الكوفيون و غيرهم من فروع الأيمان شيئا كثيرا مبناه على هذا الأصل و كثير
من الفروع الضعيفة التي يفرعها هؤلاء و نحوهم كما كان الشيخ أبو محمد
المقدسي يقول مثالها مثال رجل بنى دارا حسنة على حجارة مغصوبة فإذا نوزع
في استحقاق تلك الحجارة التي هي الأساس فاستحقها غيره انهدم بناؤه فإن تلك
الفروع الحسنة إن لم تكن على أصول محكمة و إلا لم يكن لها منفعة
فإذا كان الحلف بالطلاق و اعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد أوجب هذه
المفاسد العظيمة التي قد غيرت بعض أمور الإسلام عند من فعل ذلك وصار في
هؤلاء شبه بأهل الكتاب كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مع أن لزوم
الطلاق عند الحلف به ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا أفتى به أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد منهم فيما أعلمه ولا اتفق عليه
التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا العلماء بعدهم ولا هو مناسب لأصول
الشريعة ولا حجة لمن قاله أكثر من عادة مستمرة استندت على قياس معتضد
بتقليد لقوم أئمة علماء محمودين عند الأمة وهم ولله الحمد فوق ما يظن بهم
لكن لم نؤمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله و إلى رسوله وقد خالفهم فيه
من ليس دونهم بل مثلهم أو فوقهم فإنا قد ذكرنا عن أعيان الصحابة كعبد الله
بن عمر المجمع على إمامته و فقهه و دينه و أخته حفصة أم المؤمنين و زينب
ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أمثل فقيهات الصحابة الإفتاء
بالكفارة في الحلف بالعتق و الطلاق ما هو أولى منه و ذكرنا عن طاوس وهو من
أفاضل أفاضل علماء التابعين علما و فقها و دينا أنه لم يكن يرى اليمين
بالطلاق موقعة له
فإذا كان لزوم الطلاق عند الحنث في اليمين به مقتضيا لهذه المفاسد و حاله
في
الشريعة هذه الحال كان هذا دليلا على أن ما أفضى إلى هذا الفساد
لم يشرعه الله ولا رسوله كما نبهنا عليه في ضمان الحدائق لمن يزرعها و
يستثمرها و بيع الخضر و نحوها
و ذلك أن الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطعن رحمه أو ليعقن أباه أو ليقتلن
عدوه المسلم المعصوم أو ليأتين الفاحشة أو ليشربن الخمر أو ليفرقن بين
المرء و زوجه و نحو ذلك من كبائر الإثم و الفواحش فهو بين ثلاثة أمور إما
أن يفعل هذا المحلوف عليه فهذا لا يقوله مسلم لما فيه من ضرر الدنيا و
الآخرة مع أن كثيرا من الناس بل من المفتين إذا رآه قد حلف بالطلاق كان
ذلك سببا لتخفيف الأمر عليه و إقامة عذره
و إما أن يحتال ببعض تلك الحيل المذكورة كما استخرجه قوم من المفتين ففي
ذلك من الاستهزاء بآيات الله و مخادعته و المكر السيء بدينه و الكيد له و
ضعف العقل و الدين و الاعتداء لحدود الله و الانتهاك لمحارمه و الإلحاد في
آياته ما لا خفاء به و إن كان من إخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض ذلك
فقد دخل من الغلط في ذلك وإن كان مغفورا لصاحبه المجتهد المتقي لله ما
فساده ظاهر لمن تأمل حقيقة الدين
و إما أن لا يحتال ولا يفعل المحلوف عليه بل يطلق امرأته كما يفعله من
يخشى الله إذا اعتقد وقوع الطلاق ففي ذلك من الفساد في الدين و الدنيا ما
لا يأذن به الله ولا رسوله
أما فساد الدين فإن الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوجين باتفاق
العلماء حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن المختلعات و المنتزعات
هن المنافقات ) و قال ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس
فحرام عليها رائحة الجنة )
وقد اختلف العلماء هل هو محرم أو مكروه وفيه روايتان عن أحمد وقد استحسنوا
جواب أحمد لما سئل عمن حلف بالطلاق ليطأن امرأته وهي حائض
فقال يطلقها ولا يطأها قد أباح الله الطلاق و حرم وطء الحائض
وهذا الاستحسان يتوجه على أصلين أما على قوله إن الطلاق ليس بحرام و إنما
يكون تحريمه دون تحريم الوطء و إلا فإذا كان كلاهما حراما لم يخرج من حرام
إلا إلى حرام
و أما ضرر الدنيا فأبين من أن يوصف فإن لزوم الطلاق المحلوف به في كثير من
الأوقات يوجب من الضرر ما لم تأت به الشريعة الإسلامية في مثل هذا قط أن
المرأة الصالحة تكون في صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة وهي متاعه
التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ( الدنيا متاع و خير متاعها
المرأة المؤمنة إن نظرت إليها أعجبتك و إن أمرتها أطاعتك و إن غبت عنها
حفظتك في نفسها و مالك ) وهي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في
قوله لما سأله المهاجرون ( أي المال خير فنتخذه فقال أفضله لسان ذاكر و
قلب شاكر و امرأة صالحة تعين أحدكم على إيمانه ) رواه الترمذي من حديث
سالم بن أبي الجعد عن ثوبان و بينهما من المودة و الرحمة ما امتن الله به
في كتابه بقوله { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة } فيكون ألم الفراق أشد عليهما من الموت أحيانا و
أشد من ذهاب المال و أشد من فراق الأوطان خصوصا إن كان بقلب كل واحد منهما
حب و علاقة من صاحبه أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق و يفسد حالهم ثم
يفضي ذلك إلى القطيعة بين أقاربهما ووقوع الشر لما زالت نعمة المصاهرة
التي امتن الله بها في قوله { فجعله نسبا وصهرا } و معلوم أن هذا من الحرج
الداخل في عموم قوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } و من العسر
المنفي بقوله { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }
و أيضا فلو كان المحلوف عليه بالطلاق فعل بر و إحسان من صدقة و عتاقة و
تعليم علم و صلة رحم و جهاد في سبيل الله و إصلاح بين الناس و نحو ذلك
من الأعمال الصالحة التي يحبها الله و يرضاها فإنه لما عليه من
الضرر العظيم في الطلاق لا يفعل ذلك بل و لا يؤمر به شرعا لأنه قد يكون
الفساد الناشئ من الطلاق أعظم من الصلاح الحاصل من هذه الأعمال وهي
المفسدة التي أزالها الله بقوله { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم } و
أزالها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله
آثم عند الله من أن يأتي الكفارة التي فرض الله )
فإن قيل فهو الذي أوقع نفسه في أحد هذه المضرات الثلاث فما كان ينبغي له
أن يحلف
قيل ليس في شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة إلا
بضرر عظيم فإن الله لم يحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا فهب
أن هذا قد أتى كبيرة من الكبائر في حلفه بالطلاق ثم تاب من تلك الكبيرة
فكيف يناسب أصول شريعتنا أن يبقى أثر ذلك الذنب عليه لا يجد منه خرجا وهذا
بخلاف الذي ينشئ الطلاق لا بالحلف عليه فإنه لا يفعل ذلك إلا وهو مريد
الطلاق إما لكراهته للمرأة أو غضبه عليها و نحو ذلك وقد جعل الله الطلاق
ثلاثا فإذا كان إنما يتكلم بالطلاق باختياره ووالى ثلاث مرات متفرقات كان
وقوع الضرر في مثل هذا نادرا بخلاف الأول فإن مقصوده لم يكن الطلاق و إنما
كان أن يفعل المحلوف عليه أولا يفعله ثم قد يأمره الشرع أو تضطره الحاجة
إلى فعله أو تركه فيلزمه الطلاق بغير اختيار له ولا لسببه
و أيضا فإن الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم في باب الأيمان
تخفيفها بالكفارة لا تثقيلها بالإيجاب أو التحريم فإنهم كانوا في الجاهلية
يرون الظهار طلاقا و استمروا على ذلك في أول الإسلام حتى ظاهر أوس بن
الصامت رضي الله عنه من امرأته
و أيضا فالاعتبار بنذر اللجاج و الغضب فإنه ليس بينهما من الفرق إلا
ما ذكرناه و سنبين إن شاء الله عدم تأثيره و القياس بالفارق أصح
ما يكون من الاعتبار باتفاق العلماء المعتبرين
وذلك أن الرجل إذا قال إن أكلت أو شربت فعلي أن أعتق عبدي أو فعلي أن أطلق
امرأتي أو فعلي الحج أو فأنا محرم بالحج أو فمالي صدقة أو فعلي صدقة فإنه
تجزئة كفارة يمين عند الجمهور كما قدمناه بدلالة الكتاب و السنة و إجماع
الصحابة فكذلك إذا قال إن أكلت هذا أو شربت هذا فعلي الطلاق أو فالطلاق لي
لازم أو فامرأتي طالق أو فعبيدي أحرار و إن قال علي الطلاق لا أفعل كذا أو
الطلاق يلزمني لا أفعل كذا فهو بمنزلة قوله علي الحج لا أفعل كذا و الحج
لي لازم لا أفعل كذا و كلاهما يمينان محدثتان ليستا مأثورتين عن العرب ولا
معروفتين عند الصحابة و إنما المستأخرون صاغوا من هذه المعاني أيمانا و
ربطوا إحدى الجملتين بالأخرى كالأيمان التي كان المسلمون من الصحابة
يحلفون بها و كانت العرب تحلف بها لا فرق بين هذا و هذا إلا أن قوله إن
فعلت كذا فمالي صدقة يقتضي وجوب الصدقة عند الفعل وقوله مرأتي طالق يقتضي
وجود الطلاق فالكلام يقتضي وقوع الطلاق بنفس الشرط و إن لم يحدث بعد هذا
طلاقا ولا يقتضي وقوع الصدقة حتى يحدث صدقة
و جواب هذا الفرق الذي اعتمده الفقهاء الفرقون من وجهين
أحدهما منع الوصف الفارق في بعض الأصول المقيس عليها وفي بعض صور الفروع
المقيس عليها
و الثاني بيان عدم التأثير
أما الأول فإنه إذا قال إن فعلت كذا فمالي صدقة أو فأنا محرم أو فبعيري
هدي فالمعلق بالصفة وجود الصدقة و الإحرام و الهدي لا وجوبها كما أن
المعلق في قوله فعبدي حر و امرأتي طالق وجود الطلاق و العتق لا وجوبهما
ولهذا اختلف الفقهاء من أصحابنا و غيرهم فيما إذا قال هذا
هدي وهذا صدقة لله هل يخرج عن ملكه أولا يخرج فمن قال يخرج عن
ملكه فهو كخروج زوجه و عبده عن ملكه أكثر ما في الباب أن الصدقة و الهدي
يتملكهما الناس بخلاف الزوجة و العبد وهذا لا تأثير له و كذلك لو قال علي
الطلاق لأفعلن كذا أو الطلاق يلزمني لأفعلن كذا فهو كقوله علي الحج لأفعلن
كذا فهلا جعل المحلوف به هنا وجوب الطلاق لا وجوده كأنه قال إن فعلت كذا
فعلي أن أطلق
فبعض صور الحلف بالطلاق يكون المحلوف به صيغة وجوب كما أن بعض صور الحلف
بالنذر يكون المحلوف به صيغة وجود
و أما الجواب الثاني فنقول هب أن المعلق بالفعل هنا وجود الطلاق و العتاق
و المعلق هناك وجود الصدقة و الحج و الصيام و الإهداء أليس موجب الشرط
ثبوت هذا وجوب و ذاك الوجود عند وجود الشرط
فإذا كان عند الشرط لا يثبت ذلك الوجوب بل يجزيه كفارة يمين فكذلك عند
الشرط لا يثبت هذا الوجود بل يجزيه كفارة يمين كما لو قال هو يهودي أو
نصراني أو كافر إن فعل كذا فإن المعلق هنا وجود الكفر عند الشرط ثم إذا
وجد الشرط لم يوجد الكفر بالاتفاق بل يلزمه كفارة يمين ولا يلزمه شيء ولو
قال ابتداء هو يهودي أو نصراني أو كافر للزمه الكفر بمنزلة قوله ابتداء
عبدي حر و امرأتي طالق وهده البدنة هدي وعلي صوم يوم الخميس ولو علق الكفر
بشرط يقصد وجوده كقوله إذا أهل الهلال فقد برئت من دين الإسلام لكان
الواجب أن يحكم بكفره لكن لا يتأخر الكفر لأن توقيته دليل على فساد عقيدته
فإن قيل في الحلف بالنذر إنما عليه الكفارة فقط
قيل مثله في الحلف بالعتق و كذلك في الحلف بالطلاق كما لو قال فعلي أن
أطلق امرأتي
و من قال إنه إذا قال فعلي أن أطلق امرأتي لا يلزمه شيء فقياس
قوله في الطلاق لا يلزمه شيء ولهذا توقف طاووس في كونه يمينا
و إن قيل إنه يخير بين الوفاء به و التكفير فكذلك هنا يخير بين الطلاق و
العتق وبين التكفير فإن وطئ امرأته كان اختيارا منه للتكفير كما أنه في
الظهار يكون مخيرا بين التكفير و بين تطليقها فإن وطئها لزمته الكفارة لكن
في الظهار لا يجوز له الوطء حتى يكفر لأن الظهار منكر من القول و زور
حرمها عليه و أما هنا فقوله إن فعلت فهي طالق فهو بمنزلة قوله فعلي أن
أطلقها أو قال و الله لأطلقنها فإن طلقها فلا شيء عليه و إن لم يطلقها
فعليه كفارة يمين
يبقى أن يقال فهل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها حينئذ كما لو قال و
الله لأطلقنها الساعة و لم يطلقها أو لا تجب إلا إذا عزم على إمساكها أو
لا يجب إلا إذا وجد منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل كالذي يخير
بين فراقها و إمساكها لعيب و نحوه و كالمعتقة تحت عبد أو لا يجب بحال حتى
يفوت الطلاق قبل الحكم في ذلك كما لو قال فثلث مالي صدقة أو هدي و نحو ذلك
و الأقيس في ذلك أنه مخير بينهما على التراخي ما لم يوجد منه ما يدل على
الرضا بأحدهما كسائر أنواع الخيار
فصل
موجب نذر اللجاج و الغضب على المشهور عندنا أحد شيئينإما التكفير و إما فعل المعلق ولا ريب أن موجب اللفظ في مثل قوله إن فعلت كذا فعلي صلاة ركعتين أو صدقة ألف أو فعلي الحج أو صوم شهر هو الوجوب عند الفعل فهو مخير بين هذا الوجوب و بين وجوب الكفارة فإذا لم يستلزم الوجوب المعلق ثبت وجوب الكفارة فاللازم له أحد الوجوبين كل منهما ثابت بتقدير عدم الآخر كما في الواجب المخير
و كذلك إذا قال إذا فعلت كذا فعلي عتق هذا العبد أو تطليق هذه
المرأة أو علي أن أتصدق أو أهدي فإن ذلك يوجب استحقاق العبد
للإعتاق و المال للتصدق و البدنة للهدي
ولو أنه نجز ذلك فقال هذا المال صدقة و هذه البدنة هدي و علي عتق هذا
العبد فهل يخرج عن ملكه بذلك أو يستحق الإخراج فيه خلاف وهو يشبه قوله هذا
وقف
و أما إذا قال هذا العبد حر و هذه المرأة طالق فهو إسقاط بمنزلة قوله برئت
ذمة فلان من كذا و من دم فلان أو من قذفي فإن إسقاط حق الدم و المال و
العرض من باب إسقاط حق الملك بملك البضع و ملك اليمين
فإذا قال إن فعلت فعلي الطلاق أو فعلي العتق أو فامرأتي طالق أو فعبيدي
أحرار و قلنا إن موجبه أحد الأمرين فإنه يكون مخيرا بين وقوع ذلك و بين
وجوب الكفارة كما لو قال فهذا المال صدقة أو هذه البدنة هدي
و نظير ذلك ما لو قال إذا طلعت الشمس فعبيدي أحرار و نسائي طوالق و قلنا
التخيير إليه فإنه إذا اختار أحدهما كان ذلك بمنزلة اختياره أحد الأمرين
من الوقوع أو وجوب التكفير و أمثال ذلك
و أيضا إذا أسلم و تحته أكثر من أربع أو أختان فاختار إحداهما فهذه
المواضع التي تكون فيها الفرقة أحد اللازمين إما فرقة معين أو نوع الفرقة
لا يحتاج إلى إنشاء طلاق لكن لا يتعين الطلاق إلا بما يوجب تعيينه كما في
النظائر المذكورة
ثم إذا اختار الطلاق فهل يقع من حين الاختيار أو من حين الحنث يخرج على
نظير ذلك
فلو قال في جنس مسائل نذر اللجاج و الغضب اخترت التكفير أو اخترت فعل
المنذور فهل يتعين بالقول أو لا يتعين إلا بالفعل
إن كان التخيير بين الوجوبين تعين بالقول كما في التخيير بين النساء و بين
الطلاق و العتق و إن كان بين الفعلين لم يتعين إلا بالفعل كالتخيير
بين خصال الكفارة و إن كان بين الفعل و الحكم كما في قوله إن
فعلت كذا فعبدي حر أو امرأتي طالق أو دمي هدر أو مالي صدقة أو بدنتي هدي
تعين الحكم بالقول ولم يتعين الفعل إلا بالفعل و الله سبحانه و تعالى أعلم
آخر ما تيسر بحمد الله و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم
تم هذا الكتاب بعون الله و منته على يد كاتبه علي بن سليمان آل يحيى في
آخر جمادى الأولى سنة 1318 هجرية
الحمد لله وحده و صلى الله و سلم و بارك على من لا نبي بعده عبد الله و
رسوله الكريم محمد وعلى آله
أما بعد فقد تم طبع هذه القواعد النفيسة لشيخ الإسلام علم الإعلام الإمام
المجتهد و الفقيه المحقق تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية المتوفى سنة
728 رحمه الله و غفر لنا و له و جزاه الله عن الإسلام و المسلمين خيرا و
جمعنا به دار كرامته