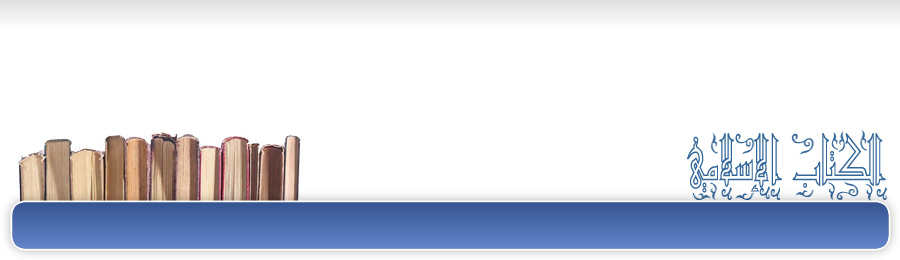الكتاب : الاعتصام
المؤلف : الشاطبي
فصل ومثال ما يقع في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية
ومثال ما يقع في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيها ومعمولا بها ومتخذة فيها كالدين المنتسب والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام ولا غيره بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعوا وهو على أنواع :فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء :
الأول منها : نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها
والثاني : نكاح الاستبضاع كالرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع
والثالث : أن يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت بإسمه فيلحق به ولدها فلا يستطيع أن يمتنع منه الرجل
والرابع : أن يجتمع الناس الكثيرون فيدخلون على المرأة لا تنمع من جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه و سلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم وهذا الحديث في البخاري مذكور
وكان لهم أيضا سنن أخر في النكاح خارجة عن المشروع كوارثة النساء كرها وكنكاح ما نكح الأب وأشباه ذلك جاهلية جارية مجرى المشروعات عندهم فمحا الإسلام ذلك كله والحمد لله
ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممن حرف التأويل في كتاب الله فأجاز نكاح أكثر من أربع نسوة إما اقتداء ـ في زعمه ـ بالنبي صلى الله عليه و سلم حيث أحل له أكثر من ذلك أن يجمع بينهن ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به عليه السلام وإما تحريفا لقوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع }
فأجاز الجمع بين تسع نسوة ذلك ولم يفهم المراد من الراوي ولا من قوله : { مثنى وثلاث ورباع } فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها
ويحكى عن الشيعة أنها تزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع الأعمال وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوعوا وأن المحظورات مباحة لهم كالخنزير والزنا والخمر وسائر الفواحش وعندهم نساء يسمين النوابات يتصدقن بفوجهن على المحتاجين رغبة في الأجر وينكحون ما شاؤوا من الأخوات والبنات والأمهات لا حرج عليهم في ذلك ولا في تكثير النساء وهؤلاء العبيدية الذين ملكوا مصر وإفريقية
ومما يحكى عنهم في ذلك أنه يكون للمرأة ثلاثة أزواج وأكثر في بيت واحد يستدلونها وتنسب الولد لكل واحد منهم ويهنأ به كل واحد منهم كما التزمت الإباحية خرق هذا الحجاب بإطلاق وزعمت أن الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام وأما الخواص منهم فقد ترقوا عن تلك المرتبة فالنساء بإطلاق حلال لهم كما أن جميع ما في الكون من رطب ويابس حلال لهم أيضا مستدلين على ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل : { قاتلهم الله أنى يؤفكون } فصاروا أضر على الدين من متبوعهم إبليس لعنهم الله كقوله :
( وكنت امرأ من جند إبليس فانتهى ... بي الفسق حتى صار إبليس من جندي ! )
( فلو مات قبلي كنت أحسن بعده ... طرائق فسق ليس يحسنها بعدي ! )
فصل ومثال ما يقع في العقل أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع
ومثال ما يقع في العقل أن الشريعة بينت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله ولذلك قال تعالى : { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } وقال تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } وقال : { إن الحكم إلا لله } وأشباه ذلك من الآيات والأحاديثفخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل له مجال في التشريع وأنه محسن ومقبح فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه
ومن ذلك أن الخمر لما حرمت ونزل من القرآن في شأن من مات قبل التحريم وهو ويشربها قوله تعالى : { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } الآية تأولها قوم ـ فيما ذكر ـ على أن الخمر حلال وأنها داخلة تحت قوله : فيما طعموا
فذكر إسماعيل بن إسحاق عن علي رضي الله عنه قال : شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان فقالوا : هي لنا حلال وتأولوا هذه الآية : { ليس على الذين آمنوا } الآية قال فكتب فيهم إلى عمر
قال : فكتب عمر إليه : أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك فلما قدموا إلى عمر استشار فيهم الناس فقالوا : يا أمير المؤمنين ! نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به فاضرب أعناقهم وعلي رضي الله عنه ساكت قال : فما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : أرى أن تستتيبهم فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشربهم الخمر وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به
فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله بنص الكتاب وشهد فيهم علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة بأنهم شرعوا في دين الله وهذه هي البدعة بعينها فهذا وجه
وأيضا فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأول فيها غير هذا وأنه إنما يشربها للنفع لا للهو وعاهد الله على ذلك فكأنها عندهم من الأدوية أو غذاء صالح يصلح لحفظ الصحة ويحكى هذا العهد عن ابن سيناء
ورأيت في بعض كلام الناس ممن عرف عنه أنه كان يستعين في سهره للعلم والتصنيف والنظر بالخمر فإذا رأى من نفسه كسلا أو فترة شرب منها قدر ما ينشطه وينفي عنه الكسل بل ذكروا فيها أن لها حرارة خاصة تفعل أفعالا كثيرة تطيب النفس وتصير الإنسان محبا للحكمة وتجعله حسن الحركة والذهن والمعرفة فإذا استعملها على الاعتدال عرف الأشياء وفهمها وتذكرها بعد النسيان
فلهذا ـ والله أعلم ـ كان ابن سينا لا يترك استعمالها ـ على ما ذكر عنه ـ وهو كله ضلال مبين عياذا بالله من ذلك
ولا يقال : إن هذا داخل تحت مسألة التداوي بها وفيها خلاف شهير لأنا نقول : إنما ثبت عن ابن سينا أنه كان يستعملها استعمال الأمور المنشطة من الكسل والحفظ للصحة والقوة على القيام بوظائف الأعمال أو ما يناسب ذلك لا في الأمراض المؤثرة في الأجسام وإنما الخلاف في استعمالها في الأمراض لا في غير ذلك فهو ومن وافقه على ذلك متقولون على شريعة الله مبتدعون فيها وقد تقدم رأي أهل الإباحة في الخمر وغيرها ولا توفيق إلا بالله
فصل ومثال ما يقع في المال أن الكفار قالوا : إنما البيع مثل الربا
ومثال ما يقع في المال أن الكفار قالوا : { إنما البيع مثل الربا } فإنهم لما استحلوا العمل به واحتجوا بقياس فاسد فقالوا : إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في خمسة عشر إلى شهرين فهو كما لو باع بخمسة عشر إلى شهرين فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم فقال : { ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا } أي : ليس البيع مثل الربا فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد فكان من جملة المحدثات كسائر ما أحدثوا في البيوع الجارية بينهم المبنية على الخطر والغرر
وكانت الجاهلية قد شرعت أيضا أشياء في الأموال كالحظوظ التي كانوا يخرجونها للأمير من الغنيمة حتى قال شاعرهم :
( لك المرباع فيها والصفايا ... وحكمك والنشيطة والفضول )
فالمرباع : ربع المغنم يأخذه الرئيس والصفايا : جمع صفي وهو ما يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم والنشيطة : ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغهم إلى الموضع الذي قصدوه فكان يختص به الرئيس دون غيره والفضول : ما يفضل من الغنيمة عند القسمة
وكانت تتخذ الأرضين تحميها عن الناس أن لا يدخلوها ولا يرعوها فلما نزل القرآن بقسمة الغنيمة في قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء } الآية راتفع حكم هذه البدعة إلا بعض من جرى في الإسلام على حكم الجاهلية فعمل بأحكام الشيطان ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى
وكذلك جاء في الحديث :
[ لا حمى إلا حمى الله ورسوله ] ثم جرى بعض الناس ممن آثر الدنيا على طاعة الله على سبيل حكم الجاهلية { ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون } ولكن الآية والحديث وما كان في معناهما أثبت أصلا في الشريعة مطردا لا ينخرم وعاما لا يتخصص ومطلقا لا يتقيد وهو أن الصغير من المكلفين والكبير والشريف والدنيء والرفيع والوضيع في احكام الشريعة سواء فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل خرج من السنة إلى البدعة ومن الاستقامة إلى الإعوجاج
وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع لعلها تذكر فيما بعد إن شاء الله وقد أشير إلى جملة منها
فصل إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة
إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم فوصف الضلالة لازم لها وشامل لأنواعها لما ثبت من قوله صلى الله عليه و سلم :[ كل بدعة ضلالة ]
لكن يبقى ها هنا إشكال وهو أن الضلالة ضد الهدى لقوله تعالى : { أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى } وقوله : { ومن يضلل الله فما له من هاد } { ومن يهد الله فما له من مضل } وأشباه ذلك مما قوبل فيه بين الهدى والضلال فإنه بقتضي أنهما ضدان وليس بينهما واسطة تعتبر في الشرع فدل على أن البدع المكروهة خروج عن الهدى
ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع المكروهة من الأفعال كالالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة
والصلاة وهو يدافعه الأخبثان وما أشبه ذلك
ونظيره في الحديث :
[ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ] فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاص مع أن الطاعة ضدها المعصية وفاعل المندوب مطيع لأنه فاعل أمر به فإذا اعتبرت الضد لزم أن يكون فاعل المكروه عاصيا لأنه فاعال ما نهي عنه لكن ذلك غير صحيح إذ لا يطلق عليه عاص فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ضالا وإلا فلا فرق بين إعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدى فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية وإلا فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية
إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة فليعم لفظ المعصية لكل فعل مكروه لكن هذا باطل فما لزم عنه كذلك
والجواب : أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة
والجواب : أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت ـ كما تقدم بسطه ـ وما التزمتم في الفعل المكروه غير لازم فإنه لا يلزم في الأفعال أن تجري على الضدية المذكورة إلا بعد استقراء الشرع ولما استقرينا موارد الأحكام الشرعية وجدنا للطاعة والمعصية واسطة متفقا عليها أو كالمتفق عليها وهي المباح وحقيقته أنه ليس بطاعة من حيث هو مباحفالمأر والنهي ضدان بينهما واسطة لا يتعلق بها أمر ولا نهي وإنما يتعلق بها التخيير
وإذا تأملنا المكروه ـ حسبما قرره الأصوليون ـ وجدناه ذا طرفين :
طرف من حيث هو منهي عنه فيستوي مع المحرم في مطلق النهي فربما يتوهم أن مخالفة نهي الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق المخالفة
غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الآخر وهو أن يعتبر من حيث لا يترتب على فاعله ذم شرعي ولا إثم ولا عقاب فخالف المحرم من هذا الوجه وشارك المباح فيه لأن المباح لا ذم على فاعله ولا إثم ولا عقاب فتحاموا أن يطلقوا على ما هذا شأنه عبارة المعصية
وإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن ينسب إليها المكروه من البدع وقد قال الله تعالى : { فماذا بعد الحق إلا الضلال } فليس إلا حق وهو الهدى وضلال وهو الباطل فالبدع المكروهة ضلال
وأما ثانيا : فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم ـ كما تقدم بيانه ـ وأما تعيين الكراهة التي معناها نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج البتة فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع ولا من كلام الأئمة على الخصوص
أماالشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم رد على من قال :
[ أما أنا فأقوم الليل ولا أنام ] وقال الآخر : [ أما أنا فلا أنكح النساء ] إلى آخر ما قالوا فرد عليهم ذلك صلى الله عليه و سلم وقال : [ من رغب عن سنتي فليس مني ]
وهذه العبارة أشد شيء في الإنكار ولم يكن ما التزموا إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر وكذلك ما في الحديث [ أنه عليه السلام رأى رجلا قائما في الشمس فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مره فليجلس وليستظل وليتم صومه ] قال مالك : أمره أن يتم ما كان لله عليه فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية
ويعضد هذا الذي قاله مالك ما في البخاري عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال :
ما لها فقال حجت مصمتة قال لها : تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت الحديث إلخ
وقال مالك أيضا في قوله عليه الصلاة و السلام :
[ من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ] إن ذلك أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام وإلى مصر وأشباه ذلك مما ليس فيه طاعة أو أن لا أكلم فلانا فليس عليه في ذلك شيء إن هو كلمه لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة وإنما يوفي لله بكل نذر فيه طاعة من مشي إلى بيت الله أو صيام أو صدقة أو صلاة فكل ما لله فيه طاعة فهو واجب على من نذره
فتأمل كيف جعل القيام في الشمس وترك الكلام ونذر المشي إلى الشام أو مصر معاصي حتى فسر فيها الحديث المشهور مع أنها في أنفسها أشياء مباحات لكنه لما أجراها مجرى ما يتشرع به ويدان لله به صارت عند مالك معاصي لله وكلية قوله : [ كل بدعة ضلالة ] شاهدة لهذا المعنى والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد وهي خاصية المحرم
وقد مر ما روى الزبير بن بكار وأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الله ! من أين أحرم ؟ قال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إني أريد أن أحرم من المسجد : فقال : لا تفعل قال : غني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر قال : لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة قال : وأي فتنة في هذا ؟ إنما هي أميال أزيدها قال : وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ إني سمعت الله تعالى يقول : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم }
فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة أشرف منه وهو مسجد الله ورسول الله صلى الله عليه و سلم وموضع قبره لكنه أبعد من الميقات فهو زيادة في التعب قصدا لرضا الله ورسوله فبين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في بادىء الرأي يخاف على صاحبه الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة واستدل بالآية فكل ما كان مثل ذلك داخل ـ عند مالك ـ في معنى الآية فأين كراهية التنزيه في هذه الأمور التي يظهر بأول النظر أنها سهلة ويسيرة ؟
وقال ابن حبيب : أخبرني ابن الماجشون أنه سمع مالكا يقول : التثويب ضلال ؟ قال مالك : ومن أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خان الدين لأن الله تعالى يقول : { اليوم أكملت لكم دينكم } فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا
وإنما التثويت الذي كرهه أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وهو قول إسحاق بن راهوية أنه التثويب المحدث
قال الترمذي لما نقل هذا عن سحنون : وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه و سلم وإذا اعتبر هذا اللفظ في نفسه فكل أحد يستسهله في بادىء الرأي إذ ليس فيه زيادة على التذكير بالصلاة
وقصة صبيغ العراقي ظاهرة في هذا المعنى فحكة ابن وهب قال : حدثنا مالك بن أنس قال : جعل صبيغ يطوف بكتاب الله معه ويقول : من يتفقه يفقهه الله من يتعلم يعلمه الله فأخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه بالجريد الرطب ثم سجنه حتى إذا خف الذي به أخرجه فضربه فقال : يا أمير المؤمنين ! إن كنت تريد قتلي فأجهز علي وإلا فقد شفيتني شفاك الله فخلاه عمر
قال ابن وهب : قال مالك وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغا حين بلغه ما يسأل عنه من القرآن وغير ذلك اهـ
وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن أمور من القرآن لا ينبني عليها عمل وربما نقل عنه أنه كان يسأل عن السابحات سبحا والمرسلات عرفا وأشباه ذلك والضرب إنما يكون لجناية أربت على كراهية التنزيه إذ لا يستباح دم امرىء مسلم ولا عرضه بمكروه كراهية تنزيه ضربه إياه خوف الابتداع في الدين أن يشتغل منه بما لا ينبني عليه عمل وأن يكون ذلك ذريعة لئلا يبحث عن المتشابهات القرآنية ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : { وفاكهة وأبا } قال : هذه الفاكهة فما الأب ! ثم قال : ما أمرنا بهذا
وفي رواية : نهينا عن التكلف
وجاء في قصة صبيغ من رواية ابن وهب عن الليث أنه ضربه مرتين ثم أراد أن يضربه الثالثة فقال له صبيغ : إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أب موسى الأشعري رضي الله عنه أن لا يجالسه أحد من المسلمين فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت سيئتة فكتب إليه عمر أن يأذن للناس بمجالسته والشواهد في هذا المعنى كثيرة وهي تدل على أن الهين عند الناس من البدع شديد وليس بهين { وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم }
وأما كلام العلماء فإنهم وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي عنها لا يعنون بها كراهية التنزيه فقط وإنما هذا اصطلاح للمتأخرين حين أرادوا أن يفرقوا بين القبلتين فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم والمنع وأشباه ذلك
وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا أن يقولوا : هذا حلال وهذا حرام ويتحامون هذه العبارة خوفا مما في الآية من قوله : { ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب } وحكى مالك عمن تقدمه هذا المعنى فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها : أكره هذا ولا أحب هذا وهذا مكروه وما أشبه ذلك فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه ؟ اللهم إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع ولكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله لا لأنه بدعة مكروهة على تفصيل يذكر في موضعه
وأما ثالثا : فإنا إذا تأملنا حقيقة البدعة ـ دقت أو جلت ـ وجدناها مخالفة للمكروه من المنهيات المخالفة التامة وبيان ذلك من أوجه :
أحدها : أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في الشريعة فهو إلى الطمع في رحمة الله أقرب وأيضا فليس عقده الإيماني بمتزحزح لأنه يعتقد المكروه مكروها كما يعتقد الحرام حراما وإن ارتكبه فهو يخاف الله ويرجوه والخوف والرجاء شعبتان من شعب الإيمان
فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل وأن نفسه الأمارة زينت له الدخول فيه ويود لو لم يفعل وايضا فلا يزال ـ إذا تذكر ـ منكسر القلب طامعا في الإقلاع سواء عليه أخذ في أسباب الإقلاع أم لا
ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الأحوال فإنه يعد ما دخل فيه حسنا بل يراه أولى بما حد له الشارع فأين مع هذه خوفه أو رجاؤه ؟ وهو يزعم أن طريقه أهدى سبيلا ونحلته أولى بالاتباع هذا وإن كان زعمه شبهة عرضت فقد شهد الشرع بالآيات والأحاديث أنه متبع للهوى وسيأتي لذلك تقرير إن شاء الله
وقد مر في أول الباب الثاني تقرير لجملة من المعاني التي تعظم أمر البدع على الإطلاق وكذلك مر في آخر الباب أيضا أمور ظاهرة في بعد ما بينهما وبين كراهية التنزيه فراجعها هنالك يتبين لك مصداق ما أشير إليه ها هنا وبالله التوفيق
والحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس
فصل إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر : وهو أن المحرم ينقسم في
الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرةإذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر : وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة ـ حسبما تبين في علم الأصول الدينية ـ فكذلك يقال في البدع المحرمة : إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها ـ كما تقدم ـ وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة ولقد اختلفوا في الفرق بينهما على أوجه وجميع ما قالوه لعله لا يوفي بذلك المقصود على الكمال فلنترك التفريع عليه
وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كتاب الموافقات أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال وكل ما نص عليه راجع إليها وما لم ينص عليه جرت في الإعتبار والنظر مجراها وهو الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه
فكذلك نقول في كبائر البدع : ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة وما لا فهي صغيرة وقد تقدمت لذلك أمثلة أول الباب فكما انحصرت كبائر المعاصي أحسن انحصار ـ حسبما أشير إليه في ذلك الكتاب ـ كذلك تنحصر كبائر البدع أيضا وعند ذلك يعترض في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يعسر التخلص عنه في إثبات الصغائر فيها وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلا وإما فرعا لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصانا منه أو تغييرا لقوافيه أو ما يرجع إلى ذلك وليس ذلك بمختص بالعبادات دون العادات وإن قلنا بدخولها في العادات بل تمنع في الجميع وإذا كانت بكليتها إخلالا بالدين فهي إذا إخلال بأول الضروريات وهو الدين وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة وقال في الفرق :
[ كلها في النار إلا واحدة ] وهذا وعيد أيضا للجميع على التفصيل
وهذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون كبائر كما أن القواعد الخمس أركان الدين وهي متفاوتة في الترتيب فليس الإخلال بالشهادتين كالإخلال بالصلاة ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان وكذلك سائرها مع الإخلال فكل منها كبيرة فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة
ويجاب عنه بأن هذا النظر يدل على ما ذكره ففي النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه :
أحدها : أنا نقول : الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال ولكنها على مراتب أدناها لا يسمى كبيرة فالقتل كبيرة وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة دونها وقطع عضو واحد كبيرة دونها وهلم جرا إلى أن تنتهي إلى اللطمة ثم إلى أقل خدش يتصور فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة كما قال العلماء في السرقة : إنها كبيرة لأنها إخلال بضرورة المال فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف بحبة فقد عدوه من الصغائر وهذا في ضرورة الدين أيضا
فقد جاء في بعض الأحاديث عن حذيفة رضي الله عنه قال :
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة ولتنقضن عرى الإيمان عروة عروة وليصلين نساء وهن حيض ـ ثم قال ـ حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما : ما بال الصلوات الخمس ؟ لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله : { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل } لا تصلن إلا ثلاثا وتقول أخرى : إنا لنؤمن بالله إيمان الملائكة ما فينا كافر حق على الله أن يحشرهما مع الدجال فهذا الأثر ـ وإن لم تلتزم عهده صحته ـ مثال من أمثلة المسألة
فقد نبه على أن في آخر الزمان من يرى أن الصلوات المفروضة ثلاث لا خمس وبين أن من النساء من يصلين وهن حيض كأنه يعني بسبب التعمق وطلب الاحتياط بالوساوس الخارج عن السنة فهذه مرتبة دون الأولى
وحكى ابن حزم أن بعض الناس زعم أن الظهر خمس ركعات لا أربع ركعات ثم وقع في العتبية قال ابن القاسم : وسمعت مالكا يقول : أول من أحدث الاعتماد في الصلاة ـ حتى لا يحرك رجليه ـ رجل قد عرف وسمي إلا أني لا أحب أن أذكره وقد كان مساء ( أي يساء الثناء عليه ) قال : قد عيب ذلك عليه وهذا مكروه من الفعل قالوا : ومساء أي يساء الثناء عليه
قال ابن رشد : جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة قاله في المدونة وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى لأن ذلك ليس من حدود الصلاة إذ لم يأت ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا عن أحد من السلف والصحابة المرضيين وهو من محدثات الأمور : انتهى
فمثل هذا ـ إن كان يعده فاعله من محاسن الصلاة وإن لم يأت به أثر ـ فيقال في مثله : إنه من كبار البدع كما يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر ونحوها بل إنما يعد مثله من صغائر البدع إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما يراد به التنزيه وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين فمثله يتصور في سائر البدع المختلفة المراتب فالصغائر في البدع ثابتة كما أنها في المعاصي ثابتة
والثاني : أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليا في الشريعة كبدعة التحسين والتقبيح العقليين وبدعة إنكار الأخبار السنية اقتصارا على القرآن وبدعة الخوارج في قولهم : لا حكم إلا لله وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعا من فروع الشريعة دون فرع بل ستجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية أو يكون الخلل الواقع جزئيا إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض كبدعة التثويب بالصلاة الذي قال فيه مالك : التثوب ضلال وبدعة الأذان والإقامة في العيدين وبدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين وما أشبه ذلك فهذا القسم لا تتعدى فيه البدعة محلها ولا تنتظم تحتها غيرها حتى تكون أصلا لها
فالقسم الأول إذا عد من الكبائر اتضح مغزاه وأمكن أن يكون منحصرا داخلا تحت عموم الثنتين والسبعين فرقة ويكون الوعيد الآتي في الكتاب والسنة مخصوصا به لا عاما فيه وفي غيره ويكون ما عدا ذلك من قبيل اللمم المرجو فيه العفو الذي لا ينحصر إلى ذلك العدد فلا قطع على أن جميعها من واحد وقد ظهر وجه انقسامها
والثالث : أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر ولا شك أن البدع من جملة المعاصي ـ على مقتضى الأدلة المتقدمة ـ ونوع من أنواعها فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدع تنقسم أيضا ولا يخصص وجوها بتعميم الدخول في الكبائر لأن ذلك تخصيص من غير مخصص ولو كان ذلك معتبرا لاستثني من تقدم من العلماء القائلين بالتقسيم قسم البدع فكانوا ينصون على أن المعاصي ما عدا البدع تنقسم إلى الصغائر والكبائر إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثناء وأطلقوا القول بالانقسام فظهر أنه شامل لجميع أنواعها
فإن قيل : إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة مطلقا وإنما يدل ذلك على أنها تتفاضل فمنها ثقيل وأثقل ومنها خفيف وأخف والخفة هل تنتهي إلى حد تعد البدعة فيه من قبيل اللمم ؟ هذا فيه نظر وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع
وأما في البدع فثبت لها أمران :
أحدهما : أنها مضادة للشارع ومراغمة له حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حد له
والثاني : أن كل بدعة ـ وإن قلت ـ تشريع زائد أو ناقص أو تغير للأصل الصحيح وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير ـ قل أو كثر ـ كفر فلا فرق بين ما قل منه وما كثر فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه أو ألحقه بالمشروع إذا لم تكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر لأن الجميع جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا بكثير
ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء فالفرق بين بدعة جزئية وبدعة كلية وقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثاني
وأما الثالث : فلا حجة فيه لأن قوله عليه السلام : [ كل بدعة ضلالة ] وما تقدم من كلام السلف يدل على عموم الذم فيها وظهر أنها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام بل إنما ينقسم ما سواها من المعاصي واعتبر بما تقدم ذكره في الباب الثاني يتبين لك عدم الفرق فيها وأقرب منها عبارة تناسب هذا التقرير أن يقال : كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبتها فيكون منها صغار وكبار إما بإعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض فالأشد عقابا أكبر مما دونه وإما بإعتبار فوت المطلوب في المفسدة فكما انقسمت الطاعة بإتباع السنة إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل والصغر والكبر من باب النسب والإضافات فقد يكون الشيء كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه
وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين لكن في انقاسم المعاصي إلى الكبائر والصغائر فقال : المرضي عندنا أن كل ذنب كبير وعظيم بالإضافة إلى مخالفة الله ولذلك يقال : معصية الله أكبر من معصية العباد قولا مطلقا إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها ثم ذكر معنى ما تقدم ولم يوافقه غيره على ما قال وإن كان له وجه في النظر وقعت الإشارة إليه في كتاب الموافقات ولكن الظاهر يأبى ذلك ـ حسبما ذكره غيره من العلماء ـ والظواهر في البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نزل عليها ـ حسبما تقدم ـ فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات كما صار اعتقاد نفي الكراهية التنزيه عنها من الواضحات
فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعط من الإنصاف حقه ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غص من جانبها بل صاحب المعصية متنصل منها مقر لله بمخالفتة لحكمها
وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة ولذلك قال مالك بن أنس : من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خان الرسالة لأن الله يقول : { اليوم أكملت لكم دينكم } إلى آخر الحكاية وقد تقدمت
ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة وقال : أي فتنة فيها ؟ إنما هي أميال أزيدها فقال : وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى آخر الحكاية وقد تقدمت أيضا فإذا يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة
فالجواب : ان ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشقيق هذه المسألة
وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالما بكونها بدعة وأن يكون غير عالم بذلك وغير العالم بكونها بدعة على ضربين وهما المجتهد في استنباطها وتشريعها والمقلد له فيها وعلى كل تقدير فالتأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا حكمنا له بحكم أهل الإسلام لأنه مصادم للشارع مراغم للشرع بالزيادة فيه أو النقصان منه أو التحريف له فلا بد له من تأويل كقوله : هي بدعة ولكنها مستحسنة أو يقول : إنها بدعة ولكني رأيت فلانا الفاضل يعمل بها أو يقر بها ولكنه يفعلها لحظ عاجل كفاعل الذنب لقضاء حظه العاجل خوفا على حظه أو فرارا من خوف على حظه أو فرارا من الاعتراض عليه في اتباع السنة كما هو الشأن اليوم في كثير ممن يشار إليه وما أشبه ذلك
وأما غير العالم وهو الواضع لها لأنه لا يمكن أن يعتقدها بدعة بل هي عنده مما يلحق المشروعات كقول من جعل يوم الإثنين يصام لأنه يوم مولد النبي صلى الله عليه و سلم وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقا بأيام الأعياد لأنه عليه السلام ولد فيه وكمن عد السماع والغناء مما يتقرب به إلى الله بناء على أنه يجلب الأحوال السنية أو رغب في الدعاء بهئية الاجتماع في أدبار الصلوات دائما بناء على ما جاء في ذلك حالة الواحدة أو زاد في الشريعة أحاديث مكذوبة لينصر في زعمه سنة محمد صلى الله عليه و سلم فلما قيل له : إنك تكذب عليه وقد قال :
[ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ] قال : لم أكذب عليه وإنما كذبت له أو نقص منها تأويلا عليها لقوله تعالى في ذم الكفار : { إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا } فأسقط اعتبار الأحاديث المنقوله بالآحاد لذلك ولما أشبه لأن خبر الواحد ظني فهذه كلها من قبل التأويل
وأما المقلد فكذلك أيضا لأنه يقول : فلان المقتدى به يعمل بهذا العمل ويثني عليه كاتخاذ الغناء جزءا من أجزاء طريقة التصوف بناء على أن شيوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه ومنهم من مات بسببه وكتمزيق الثياب عند التواجد بالرقص وسواه لأنهم قد فعلوه وأكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتمين إلى التصوف
وربما احتجوا على بدعتهم بالجنيد و البسطامي والشبلي وغيرهم فيما صح عندهم أو لم يصح ويتركون أن يحتجوا بسنة الله ورسوله وهي التي لا شائبة فيها إذا نقلها العدول وفسرها أهلها المكبون على فهمها وتعلمها ولكنهم مع ذلك لا يقرون بالخلاف للسنة بحثا بل يدخلون تحت أذيال التأويل إذ لا يرضى منتم إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة أصلا
وإذا كان كذلك فقول مالك : من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم خان الرسالة وقوله لمن أراد أن يحرم من المدينة : أي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ إلى آخر الحكاية إنها إلزام للخصم على عادة أهل النظر كأنه يقول : يلزمك في هذا القول كذا لأنه يقول : قصدت إليه قصدا لأنه لا يقصد إلى ذلك مسلم ولازم المذهب : هل هو نذهب أم لا ؟ هي مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون أنه رأي المحققين أيضا : أن لازم المذهب ليس بمذهب فلذلك إذا قرر على الخصم أنكره غاية الإنكار فإذا اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهض وعند ذلك تستوي البدعة مع المعصية صغائر وكبائر فكذلك البدع
ثم إن البدع على ضربين : كلية وجزئية فأما الكلية فهي السارية فيما لا ينحصر من فروع الشريعة ومثالها بدع الفرق الثلاث والسبعين فإنها مختصة بالكليات منها دون الجزئيات حسبما يتبين بعد إن شاء الله
وأما الجزئية فهي الواقعة في الفروع الجزئية ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنار وإن دخلت تحت الوصف بالضلال كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة أو التطفيف بحبه وإن كان داخلا تحت وصف السرقة بل المتحقق دخول عظائمها وكلياتها كالنصاب في
فصل وإذا قلنا : إن من البدع ما يكون صغيرة
وإذا قلنا : إن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط :أحدها : أن لا يدوام عليها فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه لأن ذلك ناشىء عن الإصرار عليها والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ولذلك قالوا : [ لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار ] فكذلك البدعة من غير فرق إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يصر عليها وقد لا يصر عليها وقد لا يصر عليها وعلى ذلك ينبني طرح الشهادة وسخطه الشاهد بها أو عدمه بخلاف البدعة فإن شأنها في المداومة والحرص على أن لا تزال من موضعها وأن تقوم على تاركها القيامة وتنطلق عليه ألسنة الملامة ويرمى بالتسفيه والتجهيل وينبز بالتبديع والتضليل ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة والمقتدى بهم من الأئمة والدليل على ذلك الاعتبار والنقل فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة إن كان لهم عصبة أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس وتنفذ أوامره في الأقطار ومن طالع سير المتقدمين وجد من ذلك ما لا يخفى
وأما النقل فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا وليست كذلك المعاصي فقد يتوب صاحبها وينيب إلى الله بل قد جاء ما يشد ذلك في حديث الفرق حيث جاء في بعض الروايات :
تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسبما تقدم
والشرط الثاني : أن لا يدعو إليها فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إثم ذلك كله عليه فإنه الذي أثارها وسبب كثرة وقوعها والعمل بها فإن الحديث الصحيح قد أثبت :
[ أن كل من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ] والصغيرة مع الكبيرة إنما تفاوتها بحسب كثرة الإثم وقلته فربما تساوي الصغيرة ـ من هذا الوجه ـ الكبيرة أو تربى عليها
وفي هذا الوجه قد يتعذر الخروج فإن المعصية فيما بين العبد وربه يرجو فيها من التوبة والغفران ما يتعذر عليه مع الدعاء إليها وقد مر في باب ذم البدع وباقي الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله
والشرط الثالث : أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة فأما إظهارها في المجتمعات ممن يقتدى به أو بمن يحسن به الظن فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام فإنها لا تعدو أمرين : إما أن يقتدى بصاحبها فيها فإن العوام أبتاع كل ناعق لا سيما البدع التي وكل الشيطان بتحسينها للناس والتي للنفوس في تحسينها هوى وإذا اقتدي بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر
وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي فإن العالم مثلا إذا أظهر المعصية ـ وإن صغرت ـ سهل على الناس ارتكابها فإن الجاهل يقول : لو كان هذا الفعل كما قال من أنه ذنب لم يرتكبه وإنما ارتكبه لأمر علمه دوننا فكذلك البدعة إذا أظهرها العالم المقتدى فيها لا محالة فإنها في مظنة التقرب في ظن الجاهل لأن العالم يفعلها على ذلك الوجه بل البدعة أشد في هذا المعنى إذ الذنب قد لا يتبع عليه بخلاف البدعة فلا يتحاشى أحد عن اتباعه إلا من كان عالما بأنها بدعة مذمومة فحينئذ يصير في درجة الذنب فإذا كانت كذلك صارت كبيرة بلا شك فإن كان داعيا إليها فهو أشد وإن كان الإظهار باعثا على الاتباع فبالدعاء يصير أدعى إليه
وقد روي عن الحسن أن رجلا من بني إسرائيل ابتدع بدعة فدعا الناس إليها فاتبع وأنه لما عرف ذنبه عمد إلى ترقوته فنقبها فأدخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثقها في شجرة فيجعل يبكي ويعج إلى ربه فأوحى الله إلى نبي تلك الأمة أن لا توبة له قد غفر له الذي أصاب فكيف بمن ضل فصار من أهل النار ؟
وأما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن فهو كالدعاء إليها بالتصريح لأن عمل إظهار الشرائع الإسلامية توهم أن كل ما أظهر فيها فهو من الشعائر فكأن المظهر لها يقول : هذه سنة فاتبعوها
قال أبو مصعب : قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا ـ وكان قد صلى خلف الإمام ـ فلما سلم قال : من ها هنا من الحرس ؟ فجاءه نفسان فقال : خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه : فحبس فقيل له : إنه ابن مهدي فوجه إليه وقال له : ما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في لاصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم :
[ من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ] فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك أبدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا في غيره
وفي رواية عن ابن مهدي قال : فقال : يا عبد الرحمن ! تصلي مستلبا ؟ فقلت : يا أبا عبد الله إنه كان يوما حارا ـ كما رأيت فثقل ردائي علي فقال : آلله ما أردت بذلك الطعن على من مضى والخلاف عليه ؟ قلت : آلله قال : خلياه
وحكى ابن وضاح قال : ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك فأرسل إليه مالك فجاءه فقال له مالك : ما هذا الذي تفعل ؟ فقال : أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقومون فقال له مالك : لا تفعل لا تحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم بهذا البلد عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه فكف المؤذن عن ذلك وأقام زمانا ثم إنه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجر فأرسل إليه مالك فقال له : ما الذي تفعل ؟ قال : أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال له : ألم أنهك أن لا تحدث عندنا ما لم يكن ؟ فقال : إنما نهيتني عن التثويب فقال له : لا تفعل فكف زمانا ثم جعل يضرب الأبواب فأرسل إليه مالك فقال : ما هذا الذي تفعل : أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال له مالك : لا تفعل لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه
قال ابن وضاح : وكان مالك يكره التثويب ـ قال ـ وإنما أحدث هذا بالعراق قيل ل ابن وضاح : فهل كان يعمل به بمكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من الأمصار ؟ فقال : ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والإباضيين
فتأمل كيف منع مالك من إحداث أمر يخف شأنه عند الناظر فيه ببادىء الرأي وجعله أمرا محدثا وقد قال في التثويب : إنه ضلال وهو بين لأن :
[ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ] ولم يسامح للمؤذن في التنحنح ولا في ضرب الأبواب لأن ذلك جدير بأن يتخذ سنة كما منع من وضع رداء عبد الرحمن بن مهدي خوف أن يكون حدثا أحدثه
وقد أحدث بالمغرب المتسمى بالمهدي تثويبا عند طلوع الفجر وهو قولهم أصبح ولله الحمد إشعارا بأن الفجر قد طلع لإلزام الطاعة ولحضور الجماعة وللغد ولكل ما يؤمرون به فيخصه هؤلاء المتأخرون تثويبا بالصلاة كالأذان ونقل أيضا إلى أهل المغرب الحزب المحدث بالإسكندرية وهو المعتاد في جوامع الأندلس وغيرها فصار ذلك كله سنة في المساجد إلا الآن فإنا لله وإنا إليه راجعون
وقد فسر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا نظير قولهم عندنا : الصلاة ـ رحمكم الله
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل مسجدا أراد أن يصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال : اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه قال ابن رشد : وهذا نحو مما كان يفعل عندنا بجامع قرطبة من أن يفرد المؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله : حي على الصلاة : ثم ـ قال ـ وقيل : إنما عنى بذلك قول المؤذن في أذانه : حي على خير العمل لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة ووقع في المجموعة : أن من سمع التثويب وهو في المسجد خرج عنه كفعل ابن عمر رضي الله عنهما
وفي المسألة كلام المقصود منه التثويب المكروه الذي قال فيه مالك : إنه ضلال والكلام يدل على التشديد في الأمور المحدثة أن تكون في مواضع الجماعة أو في المواطن التي تقام فيها السنن والمحافظة على المشروعات أشد المحافظة لأنها إذا أقيمت هنالك أخذها الناس وعملوا بها فكان وزر ذلك عائدا على الفاعل أولا فيكثر وزره ويعظم خطر بدعته
والشرط الرابع : أن لا يستصغرها ولا يستحقرها ـ وإن فرضناها صغيرة ـ فإن ذلك استهانة بها والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب فكان ذلك سببا لعظم ما هو صغير وذلك أن الذنب له نظران : نظر من جهة رتبته في الشرط ونظر من جهة مخالفة الرب العظيم به فأما النظر الأول فمن ذلك الوجه يعد صغيرا إذا فهمنا من الشرع أنه صغير لأنا نضعه حيث وضعه الشرع وأما الآخر فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به حيث نستحرم جهة الرب سبحانه بالمخالفة والذي كان يجب في حقنا أن نستعظم ذلك جدا إذ لا فرق في التحقيق بين المواجهتين ـ المواجهة بالكبيرة والمواجهة بالصغيرة
والمعصية من حيث هي معصية لا يفارقها النظران في الواقع أصلا لأن تصورها موقوف عليهما فالاستعظام لوقوعها مع كونها يعتقد فيها أنها صغيرة لا يتنافيان لأنهما اعتباران من جهتين : فالعاصي وإن كان يعمل المعصية لم يقصد بتعمده الاستهانة بالجانب العلي الرباني وإنما قصد اتباع شهوته مثلا فيما جعله الشارع صغيرا أو كبيرا فيقع الإثم على حسبه كما أن البدعة لم يقصد بها صاحبها منازعة الشارع ولا التهاون بالشرع وإنما قصد الجري على مقتضاه لكن بتأويل زاده ورجحه على غيره بخلاف ما إذا تهاون بصغرها في الشرع فإنه إنما تهاون بمخالفة الملك الحق لأن النهي حاصل ومخالفته حاصلة والتهاون بها عظيم ولذلك يقال : لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى عظيمة من واجهته بها
وفي الصحيح [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في حجة الوداع : أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم الحج الأكبر قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا لا يجني جان إلا على نفسه ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده ألا وإن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا ولا تكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به ] فقوله عليه الصلاة و السلام : [ فسيرضى به ] دليل على عظم الخطب فيما يستحقر
وهذا الشرط مما اعتبره الغزالي في هذا المقام فإنه ذكر في الإحياء أن مما تعظم به الصغيرة أن يستصغرها ( قال ) : فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله وكلما استصغره كبر عند الله بين ذلك وبسطه
فإذا تحصلت هذه الشروط فإذ ذاك يرجى أن تكون صغيرتها صغيرة فإن تخلف شرط منها أو أكثر صارت كبيرة أو خيف أن تصير كبيرة كما أن المعاصي كذلك والله أعلم
الباب السابع : في الابتداع هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية ؟
قد تقدم في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيه : هل يدخل في الأمور العادية أم لا ؟ أما العبادية فلا إشكال في دخوله فيها وهي عامة الباب إذ الأمور العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية وإما أعمال جوارح من قول أو فعل وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع كمذهب القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة وكذلك مذهب الإباحة واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا أصل مرجوع إليه
وأما العادية فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها وأمثلتها ظاهرة مما تقدم في تقسيم البدع كالمكوس والمحدثة من المظالم وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية وتولية المناصب الشريفة من ليس لها بأهل بطريق الوراثة وإقامة صور الأئمة وولاة الأمور والقضاة واتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان ولبس الطيالس وتوسيع الأكمام وأشباه ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح فإنها أمور جرت في الناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت فلحقت بالبدع وصارت كالعبادات المخترعة الجارية في الأمة وهذا من الأدلة الدالة على ما قلنا وإليه مال القرافي وشيخه ابن عبد السلام وذهب إليه بعض السلف
فروى أبو نعيم الحافظ عن محمد بن أسلم أنه ولد له ولد ـ قال محمد بن القاسم الطوسي ـ فقال : اشتر لي كبشين عظيمين ودفع إلي دراهم فاشتريت له وأعطاني عشرة أخرى وقال لي : اشتر بها دقيقا ولا تنخله واخبزه قال : فنخلت الدقيق وخبزته ثم جئت به فقال : نخلت هذا ؟ وأعطاني عشرة أخرى وقال : اشتر به دقيقا ولا تنخله واخبزه وحملته إليه فقال لي : يا أبا عبد الله العقيقة سنة ونخل الدقيق بدعة ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة ولم أحب أن يكون ذلك الخبز في بيتي بعد أن كان بدعة ومحمد بن أسلم هذا هو الذي فسر به الحديث إسحاق بن راهوية حيث سئل عن السواد الأعظم في قوله عليه الصلاة و السلام :
[ عليكم بالسواد الأعظم ] فقال : محمد واصحابه حسبما يأتي ـ إن شاء الله ـ في موضعه من هذا الكتاب
وأيضا فإن تصور في العبادات وقوع الابتداع وقع في العادات لأنه لا فرق بينهما فالأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية فكلاهما مشروع من قبل الشارع فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر
ووجه ثالث وهو أن الشرع جاء بالوعد بأشياء تكون في آخر الزمان هي خارجة عن سنته فتدخل فيما تقدم تمثيله لأنها من جنس واحد
ففي الصحيح عن عبد الله رضي الله عنه قال : [ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم ] وعن ابن عباس رضي الله عنهما [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
من كره من أميره شيئا فليصبر ] وفي رواية [ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية ]
وفي الصحيح أيضا :
[ إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة ] و [ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قال : يا رسول الله أيما هو ؟ قال : القتل القتل ] وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم :
[ إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل ]
و [ عن حذيفة رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا : أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة ] وحدثنا عن رفعها ثم قال : [ ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه ينتثر وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال : إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل : ما أعقله ! وما أظرفه ! وما أجلده ! وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ] الحديث
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
[ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول وحتى يقبض العلم ثم قال : وحتى يتطاول الناس في البنيان ] إلى آخر الحديث
وعن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
[ يخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ]
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة و السلام قال : [ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض الدنيا ] وفي ذلك الحسن قال : يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويمسي مستحلا له كأنه تأوله على الحديث الآخر
[ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ] والله أعلم
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد ]
ومن غريب حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
[ إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء قيل : وما هي يا رسول الله ؟ قال : إذا صار المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا أو مسخا وقذفا ]
وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قريب من هذا
وفيه : [ ساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم ] وفيه : [ ظهرت القيان والمعازف ] وفي آخره : [ فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع ]
فهذه الأحاديث وأمثالها مما أخبر به النبي صلى الله عليه و سلم أنه يكون في هذه الأمة بعده إنما هو ـ في الحقيقة ـ تبديل الأعمال التي كانوا أحق بالعمل بها فلما عوضوا منها غيرها وفشا فيها كأنه من المعمول به تشريعا كان من جملة الحوادث الطارئة على نحو ما بين في العبادات
والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات لا يسلمون جميع ما قاله الأولون
أما ما تقدم عن القرافي وشيخه فقد مر الجواب عنه فإنها معاص في الجملة ومخالفات للمشروع كلمكوس والمظالم وتقديم الجهال على العلماء وغير ذلك
والمباح منها كالمناخل إن فرض مباحا ـ كما قالوا ـ فإنما إباحته بدليل شرعي فلا ابتداع فيه
وإن فرض مكروها ـ كما أشار إليه محمد بن أسلم ـ فوجه الكراهية عنده كونها عدت من المحدثات إذ في الأمر : أول ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم المناخل ـ أو كما قال ـ فأخذه بظاهر اللفظ من أخذ به كمحمد بن أسلم
وظاهره أن ذلك من ناحية السرف والتنعم الذي أشار إلى كراهيته قوله تعالى : { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا } الآية لا من جهة أنه بدعة
وقولهم : كما يتصور ذلك في العبادات يتصور في العادات مسلم وليس كلامنا في الجواز العقلي وإنما الكلام في الوقوع وفيه النزاع
وأما ما احتجوا به من الأحاديث فليس فيها على المسألة دليل واحد إذ لم ينص على أنها بدع أو محدثات أو ما يشير إلى ذلك المعنى وأيضا إن عدوا كل محدث العادات بدعة فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعا وهذا شنيع فإن من العوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة والإسم فيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم هذا من المستنكر جدا
نعم لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى الكلام والسنة
وأيضا فقد يكون التزام الزي الواحد والحالة الواحدة أو العادة الواحدة تعبا ومشقة لاختلاف الأخلاق والأزمنة والأحوال والشريعة تأبى التضييق والحرج فيما دل الشرع على جوازه ولم يكن ثم معارض
وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة إلى متقدم الزمان فإن الخير كان أظهر والشر كان أخفى وأقل بخلاف آخر الزمان فإن الأمر فيه على العكس والشر فيه أظهر والخير أخفى
وأما كون تلك الأشياء بدعا فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة فراجع النظر فيها تجده كذلك
والصواب في المسألة طريقة أخرى وهي تجمع شتات النظرين وتحقق المقصود في الطريقتين وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الباب فلنفرده في فصل على حدته والله الموفق للصواب
فصل أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين
أفعال المكلفين ـ بحسب النظر الشرعي فيها ـ على ضربين : أحدهما : أن يكون من قبيل التعبدات والثاني : أن يكون من قبيل العاداتفأما الأول : فلا نظر فيه ها هنا
وأما الثاني : وهو العادي فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة تختلف فيها فمنهم من يرشدألأ كلامه إلى أن العاديات كالعباديات فكما أنا مأمورون في العبادات بأن لا نحدث فيها فكذلك العاديات وهو كلام محمد بن اسلم حيث كره في سنة العقيقة مخالة من قبله في أمر عادي وهو استعمال المناخل مع العلم بأنه معقول المعنى نظرا منه ـ والله أعلم ـ إلى أن الأمر باتباع الأولين على العموم غلب عليه جهة التعبد ويظهر أيضا من كلام من قال : أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم المناخل
ويحكى عن الربيع بن أبي راشد أنه قال : لولا أني أخاف من كان قبلي لكانت الجبانة مسكني إلى أن أموت والسكنى أمر عادي بلا إشكال
وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العباديات فدخول الابتداع فيه ظاهر والأكثرون على خلاف هذا وعليه نبني الكلام فنقول :
ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي لأن أحكامها معقولة المعنى ولا بد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها كانت اقتضاء أو تخييرا فإن التخيير في التعبدات إلزام كما أن الاقتضاء إلزام ـ حسبما تقرر برهانه في كتاب الموافقات ـ وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعباديات وإلا فلا
وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب ويتبين ذلك بالأمثلة فمما أتى به القرافي من جواز وضع المكوس في معاملات الناس فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما أو في حالة ما لنيل حطام الدنيا على هئية غصب الغاصب وسرقة السارق وقطع القاطع للطريق وما أشبه ذلك أو يكون على قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع والأمر المحتوم عليهم دائما أو في أوقات محدودة على كيفيات مضروبة بحيث تضاهي المشروع الدائم الذي يحمل عليه العامة ويؤخذون به وتوجه على الممتنع منه العقوبة كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك
فأما الثاني فظاهر أنه بدعة إذ هو تشريع زائدة وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في أموال الغصاب والمتعبدين بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة أو ما أشبه ذلك فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك لأنه شرع مستدرك وسن في التكليف مهيع فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران : نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف فاجتمع فيها نهيان : نهي عن المعصية ونهي عن البدعة وليس ذلك موجودا في البدع في القسم الأول وإنما يوجد به النهي من جهة كونها تشريعا موضوعا على الناس أمر وجوب أو ندب إذ ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية بل نفس التشريع هو نفس الممنوع
وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشريفة من لا يصلح بطريق التوريث هو من قبيل ما تقدم فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتيا في الدين ومعمولا بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها محرم في الدين وكون ذلك يتخذ ديدنا حتى يصير الابن مستحقا لرتبة الأب ـ وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب ـ بطريق الوراثة أو غير ذلك بحيث يشيع هذا العمل ويطرد ويرده الناس كالشرع الذي لا يخالف بدعة بلا إشكال زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم وهو بدعة أو سبب البدعة كما سيأتي تفسيره إن شاء الله وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه و سلم بقوله :
[ حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ] وإنما ضلوا لأنهم أفتوا بالرأي إذ ليس عندهم علم
وأما إقامة الأئمة والقضاء وولاة الأمر على خلاف ما كان عليه السلف فقد تقدم أن البدعة لا تتصور هنا وذلك صحيح فإن تكلف أحد فيها ذلك فيبعد جدا وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعا خارجا عن قبيل المصالح المرسلة بحيث يعد من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به أو يكون ذلك مما يعد خاصا بالأئمة دون غيرهم كما يزعم بعضهم : أن خاتم الذهب جائز لذوي السلطان أو يقول : إن الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم
ويشبهه على قرب زخرفة المساجد إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الأثمان حتى يعد الإنفاق في ذلك إنفاقا في سبيل الله وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفيع الإسلام وإظهار معالمه وشعائره أو قصد ذلك في فعله أولا بأنه ترفيع للإسلام لما لم يأذن الله به وليس ما حكاه القرافي عن معاوية من قبيل هذه الزخارف بل من قبيل المعتاد في اللباس والاحتياط في الحجاب مخافة من انخراق خرق يتسع فلا يرفع ـ هذا إن صح ما قال وإلا فلا يعول على نقل المؤرخين ومن لا يعتبر من المؤلفين وأحرى ألا ينبني عليه حكم
وأما مسألة المناخل فقد مر ما فيها والمعتاد فيها أنه لا يلحقها أحد بالدين ولا بتدبير الدنيا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع فلا نطول به وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله ابن عبد السلام من غير فرق فتبين مجال البدعة في العاديات من مجال غيرها وقد تقدم أيضا فيها كلام فراجعه إن احتجت إليه
وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العاديات على ما أريد تحقيقه فنقول : إن مدارك تلك الأحاديث على بضع عشرة خصلة يمكن ردها إلى أصول هي كلها أو غالبها بدع وهي قلة العلم وظهور الجهل والشح وقبض الأمانة وتحليل الدماء والزنا والحرير والغناء والربا والخمر وكون المغنم دولا والزكاة مغرما وارتفاع الأصوات في المساجد وتقديم الأحداث ولعن آخر الأمة أولها وخروج الدجالين ومفارقة الجماعة
أما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب التفرغ للدنيا وهذا إخبار بمقدمة أنتجتها الفتيا بغير علم ـ حسبما جاء في الحديث الصحيح :
[ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ] إلى آخره ـ وذلك أن الناس لا بد لهم من قائد يقودهم في الدين بجرائمهم وإلا وقع الهرج وفسد النظام فيضطرون إلى الخروج إلى من انتصب لهم منصب الهداية وهو الذي يسمونه عالما فلا بد أن يحملهم على رأيه في الدين لأن الفرض أنه جاهل فيضلهم عن الصراط المستقيم : كما إنه ضال عنه وهذا عين الابتداع لأنه التشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل العلماء وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فتؤتى الناس من قبله وسيأتي لهذا المعنى بسط أوسع من هذا إن شاء الله
وأما الشح فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام وذلك أن الناس يشحون بأموالهم فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس ويليه أنواع القرض الجائز ويليه التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر وبالإسقاط كما قال : { وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون } وهذا كان شأن من تقدم من السلف الصالح ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول فتسامح الناس بالقرض ثم نقض ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه فيضطر المعسر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع كالربا والسلف الذي يجر النفع فيجعل بيعا في الظاهر ويجري في الناس شرعا شائعا ويدين له العامة وينصبون هذه المعاملات متاجر وأصلها الشح بالأموال وحب الزخارف الدنيوية والشهوات العاجلة فإذا كان كذلك فالحري أن يصير ذلك ابتداعا في الدين وأن يجعل من أشراط الساعة
فإن قيل : هذا انتجاع من مكان بعيد وتكلف لا دليل عليه فالجواب : أنه لولا أن ذلك مفهوم من الشرع لما قبل به فقد روى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
[ إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم ]
ورواه أبو داود أيضا وقال فيه :
[ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ]
فتأملوا كيف قرن التبايع بالعينة بضنة الناس فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون عن الشح بالأموال وهو معقول في نفسه فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع وهو يجد من يسلفه أو من يعينه في حاجته إلا أن يكون سفيها لا عقل له
ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود أيضا عن علي رضي الله عنه قال :
سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى : { وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين } وينشد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر ألا أن بيع المضطر حرام : الكسلك أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه
وهذه الأحاديث الثلاثة ـ وإن كانت أسانيدها ليست هناك ـ مما يعضد بعضه بعضا وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع قال بعضهم : عامة العينة إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض إلا أن يربحه في المائة ما أحب فيبيعها ثمن المائة بضعفها أو نحو ذلك ففسر بيع المضطر ببيع العينة وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى أجل ـ حسبما هو مبسوط في الفقهيات ـ فقد صار الشح إذا سببا في دخول هذه المفاسد في البيوع
فإن قيل : كلامنا في البدعة في فساد المعصية لأن هذه الأشياء بيوع فاسدة فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه
فالجواب : أن مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس فقد عده العلماء من البدع المحدثات حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل : من وضع هذا فهو كافر ومن سمع به فرضي به فهو كافر ومن حمله من كورة فهو كافر ومن كان عنده فرضي به فهو كافر وذلك أنه وقع فيه الاحتيالات بأشياء منكرة حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد
وقال إسحاق بن راهوية عن سفيان بن عبد الملك : أن ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالإرتداد وذلك في أيام أبي غشان : فذكر شيئا ثم قال ابن المبارك وهو مغضب : أحدثوا في الإسلام ومن كان أمر بهذا فهو كافر ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر أو صوبه ولم يأمر به فهو كافر ثم قال ابن مبارك : ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ ولو كان يحسنها لم يجد من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء
وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالا وللواجب حتى يكون غير واجب وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين كما أجازوا نكاح المحلل وهو احتيال على رد المطلقة ثلاثا لمن طلقها وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة وأشباه ذلك فقد ظهر وجه الإشارة في الأحاديث المتقدمة المذكور فيها الشح وأنها تتضمن ابتداعا كما تتضمن معاصي جمة
وأما قبض الأمانة فعبارة عن شياع الخيانة وهي من سماة أهل النفاق ولكن يوجد في الناس بعض أنواعها تشريعا وحكيت عن قوم ممن ينتمي إلى العلم كما حكيت عن كثير من الأمراء فإن أهل الحيل المشار إليهم إنما بنوا في بيع العينة على إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسدا فأخفوه لتظهر صحته فإن بيعه الثوب بمائة وخمسين إلى أجل لكنهما أظهرا وساطة الثوب وأنه هو المبيع والمشتري وليس كذلك بدليل الواقع
وكذلك يهب ماله عند رأس الحول قائلا بلسان حاله ومقاله : انا غير محتاج إلى هذا المال وأنت أحوج إليه مني ثم يهبه فإذا جاء الحول الآخر قال الموهوب له للواهب مثل المقالة الأولى والجميع في الحالين بل في الحولين في تصريف المال سواء أليس هذا خلاف الأمانة ؟ والتكليف من أصله أمانة فيما بين العبد وربه فالعمل بخلاف خيانة
ومن ذلك أن بعض الناس كان [ يحفر الزينة ويرد من الكذب ] ومعنى الزينة التدليس بالعيوب وهذا خلاف الأمانة والنصح لكل مسلم وايضا فإن كثيرا من الأمراء يحتاجون أموال الناس اعتقادا منهم أنها لهم دون المسلمين ومنهم من يعتقد نوعا من ذلك في الغنائم المأخوذة عنوة من الكفار فيجعلونها في بيت المال ويحرمون الغانمين من حظوظهم منها تأويلا على الشريعة بالعقول فوجه البدعة ها هنا ظاهر
وقد تقدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الباب قبل هذا ويدخل تحت هذا النمط كون الغنائم تصير دولا وقوله :
[ سترون بعدي أثرة وأمراء تنكرونها ثم قال : أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم ]
وأما تحليل الدماء والربا والحرير والغناء والخمر فخرج أبو داود و أحمد وغيرهما عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
[ لبشرين ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ] ـ زاد ابن ماجه ـ [ يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير ] وخرجه البخاري عن أبي عامر وأبي مالك الأشعري قال فيه :
[ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقولون : ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ] وفي سنن أبي داود : [ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير ] ـ وقال في آخره ـ [ يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ]
والخز هنا نوع من الحرير ليس الخز المأذون فيها المنسوج من حرير وغيره وقوله في الحديث : [ ولينزلن أقوام ] يعني ـ والله أعلم ـ من هؤلاء المستحلين والمعنى إن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب علم وهو الجبل فيواعدهم إلى الغد فيبيتهم الله ـ وهو أخذ العذاب ليلا ـ ويمسخ منهم آخرين كما في حديث أبي داود كما في الحديث قبل : يخسف الله بهم الأرض ويمسخ منهم قردة وخنازير وكأن الخسف ها هنا التبييت المذكور في الآخر
وهذا نص في أن هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين فيها حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وإنما له اسم آخر إما النبيذ أو غيره وإنما الخمر عصير العنب النيء وهذا رأي طائفة من الكوفيين وقد ثبت أن كل مسكر خمر
قال بعضهم : وإنما أتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الإسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته قال : وهذه بعينها شبهة اليهود في استحلالهم أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة حيث قالوا : ليس هذا بصيد ولا عمل يوم السبت وليس هذا باستباحة السبت
بل الذي يستحل الخمر زاعما أنه ليس خمرا مع علمه بأن معناه الخمر ومقصوده مقصود الخمر أفسد تأويلا من جهة أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياسا فلئن كان من القياس ما هو حق فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر العصيرة من القياس في معنى الأصل وهو من القياس الجلي إذ ليس بينهما من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحريم
فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالا لها لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب النيء فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف أظهر بأنه أبيح الحرير للنساء مطلقا وللرجال في بعض الأحوال فكذلك الغناء والدف قد أبيح في العرس ونحو وابيح منه الحداء وغيره وليس في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمر فظهر ذم الذين يخسف بهم ويمسخون إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء
وقد خرج ابن بطة عن الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال [ يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الربا بالبيع ] قال بعضهم : يعني العينة وروي في استحلال الربا حديث رواه إبراهيم الحربي عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
[ أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والخز ] يريد استحلال الفروج الحرام والحر بكسر الحاء المهملة والراء المخففة الفرج قالوا : ويشبه ـ والله أعلم ـ أن يراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرمة فإن الأمة لم يستحل أحد منها الزنا الصريح ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل فإن هذا لم يزل معمولا في الناس ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالا والواقع كذلك فإن هذا الملك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في أواخر عصر التابعين في تلك الأزمان صار في أولي الأمر من يفتي بنكاح المحلل ونحوه ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلا
ويؤيد ذلك أنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ لعن آكل الربا وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له ]
وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله ] فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر أن العينة من الربا وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا قال : [ يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء : يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها والسحت بالهدية والقتل بالريبة والزنا بالنكاح والربا بالبيع ] فإن الثلاثة المذكورة أولا قد سنت وأما السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم ونحوهما بإسم الهدية فهو ظاهر واستحلال القتل بإسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسية وأبهة الملك ونحو ذلك فظاهر أيضا وهو نوع من أنواع شريعة القتل المخترعة
وقد وصف النبي صلى الله عليه و سلم الخوارج بهذا النوع من الخصال فقال : [ إن من ضئضىء هذا قوما يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ] ولعل هؤلاء المرادون بقوله عليه الصلاة و السلام في حديث أبي هريرة رضي الله عته :
[ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ] الحديث يدل عليه تفسير الحسن قال ك يصبح محرما لدم أحيه وعرضه ويمسي مستحلا إلى آخره
وقد وضع القتل شرعا معمولا به على غير سنة الله وسنة رسوله المتسمي بالمهدي المغربي الذي زعم أنه المبشر به في الأحاديث فجعل القتل عقابا في ثمانية عشر صنفا ذكروا منها : الكذب والمداهنة وأخذهم أيضا بالقتل في ترك امتثال أمر من يستمع أمره وبايعوه على ذلك وكان يعظهم في كل وقت ويذكرهم ومن لم يحضر أدب فإن تمادى قتل وكل من لم يتأدب بما أدب به ضرب بالسوط المرة والمرتين فإن ظهر منه عناد في ترك امتثال الأوامر قتل ومن داهن على أخيه أو أبيه أو من يكرم أو المقدم عليه قتل وكل من شك في عصمته قتل أو شك في أنه المهدي المبشر به وكل من خالف أمره أمر اصحابه فعروه فكان أكثر تأديبه القتل ـ كما ترى ـ كما أنه كان من رأيه أن لا يصلي خلف إمام أو خطيب يأخذ أجرا على الإمامة أو الخطابة وكذلك لبس الثياب الرفيعة ـ وإن كانت حلالا ـ فقد حكوا عنه قبل أن يستفحل أمره أنه ترك الصلاة خلف خطيب أغمات بذلك السبب فقدم خطيب آخر في ثياب حفيلة تباين التواضع ـ بزعمهم ـ فترك الصلاة خلفه
وكان من رأيه ترك الرأي واتباع مذاهب الظاهرية قال العلماء : وهو بدعة ظهرت في الشريعة بعد المائتين ومن رأيه أن التمادي على ذرة من الباطل كالتمادي على الباطل كله
وذكر في كتاب الإمامة أنه هو الإمام وأصحابه هم الغرباء الذين قيل فيهم :
[ بدىء الإسلام غريبا وسيعود كما بديء فطوبى للغرباء ] وقال في الكتاب المذكور : جاء الله بالمهدي وطاعته صافية نقية لم ير مثلها قبل ولا بعد وأن به قامت السموات والأرض وبه تقوم ولا ضد له ولا مثل ولا ند انتهى وكذب فالمهدي عيس عليه السلام
وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب فأمر المؤذنين إذا طلع الفجر أن ينادوا : أصبح ولله الحمد إشعارا ـ زعموا ـ بأن الفجر قد طلع لإلزام الطاعة ولحضور الجماعة وللغدو لكل ما يؤمرون به
وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرنا وجميع ذلك إلى أنه قائل برأيه في العبادات والعادات مع زعمه أنه قائل بالرأي وهو التناقض بعينه فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع
وأما كون الزكاة مغرما فالمغرم ما يلزم أداؤه من الديون والغرامات كان الولاة يلزمونها الناس بشيء معلوم من غير نظر إلى قلة مال الزكاة أو كثرته أو قصوره عن النصاب أو عدم قصوره بل يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت وكون هذا بدعة ظاهر
وأما ارتفاع الأصوات في المساجد فناشىء عن بدعة الجدال في الدين فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن يكون في المساجد ومن آدابه أن لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجد فما ظنك به في المساجد ؟ فالجدال فيه زيادة الهوى فإنه غير مشروع في الأصل فقد جعل العلماء من عقائد الإسلام ترك المراء والجدال في الدين وهو الكلام فيما لم يؤذن في الكلام فيه كالكلام في المتشابهات من الصفات والأفعال وغيرهما وكمتشابهات القرآن ولأجل ذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قلت : [ تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الآية : { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات } قال : فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فأحذروهم ] وفي الحديث :
[ ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل ] وجاء عنه عليه السلام أنه قال : [ لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر ] وعنه عليه السلام أنه قال : [ إن القرآن يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض ما علمتم منه فاقبلوه وما لم تعلموه فكلوه إلى عالمه ] وقال عليه السلام : [ اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه ] وخرج ابن وهب عن معاوية بن قرة قال : إياكم والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال
وقال النخعي في قوله تعالى : { وألقينا بينهم العداوة والبغضاء } قال : الجدال والخصومات في الدين
وقال معن بن عيسى : انصرف مالك يوما إلى المسجد وهو متكىء على يدي فلحقه رجل يقال له أبو الجديرة يتهم بالإرجاء فقال : يا أبا عبد الله ! اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك برأيي فقال له : احذر أن اشهد عليك قال : والله ما اريد إلا الحق اسمع مني فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم قال : فإن غلبتني ؟ قال : اتبعني قال : فإن غلبتك ؟ قال : اتبعتك قال : فإن جاء رجل فكلمناه فغلبناه ؟ قال : اتبعنا فقال له مالك : يا عبد الله ! بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تنتقل
وقال عمر بن عبد العزيز : من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل
وقال مالك : ليس الجدال في الدين بشيء
والكلام في ذم الجدال كثير فإذا كان مذموما فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين ولما كان اتباع الهوى أصل الابتداع لم يعدم صاحب الجدال أن يماري ويطلب الغلبة وذلك مظنة رفع الأصوات
فإن قيل : عددت رفع الأصوات من فروع الجدال وخواصه وليس كذلك فرفع الأصوات قد يكون في العلم ولذلك كره رفع الأصوات في المسجد وإن كان في العلم أو في غير العلم
قال ابن القاسم في المبسوط : رأيت مالكا يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في المسجد
وعلل ذلك محمد بن مسلمة بعلتين : إحداهما : أنه يحب أن ينزه المسجد عن مثل هذا لأنه أمر بتعظيمه وتوقيره والثانية : انه مبني للصلاة وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة والوقار فأن يلزم ذلك في موضعها المتخذ لها أولى
وروى مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبه بين ناحية المسجد تسمى البطيحاء وقال : من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة فإذا كان كذلك فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدل المنهي عنه ؟
فالجواب من وجهين :
أحدهما : أن رفع الصوت من خواص الجدل المذموم أعني في أكثر الأمر دون الفلتات لأن رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشىء عن الهوى في الشيء المتكلم فيه واقرب الكلام الخاص بالمسجد إلى رفع الصوت الكلام فيما لم ياذن فيه وهو الجدال الذي نبه عليه الحديث المتقدم
وأيضا لم يكثر الكلام جدا في نوع من أنواع العلم في الزمان المتقدم إلا في علم الكلام وإلى غرضه تصويب سهام النقد والذم فهو إذا هو وقد روي عن عميرة بن أبي ناجية المصري أنه رأى قوما يتعارون في المسجد وقد علت أصواتهم فقال : هؤلاء قوم قد ملوا العبادة وأقبلوا على الكلام اللهم أمت عميرة فمات من عامة ذلك في الحج فرأى رجل في النوم قائلا يقول : مات في هذه الليلة نصف الناس فعرفت تلك الليلة فجاء موت عميرة هذا
والثاني : أنا لو سلمنا أن مجرد رفع الأصوات يدل على ما قلنا لكان أيضا من البدع إذا عد كأنه من الجائز في جميع أنواع العلم فصار معمولا به لا نفي ولا يكف عنه فجرى مجرى البدع المحدثات
وأما تقديم الأحداث على غيرهم فمن قبيل ما تقدم في كثرة الجهال وقلة العلم كان ذلك التقديم في ريب العلم أو غيره لأن الحدث أبدا أو في غالب الأمر غر لم يتحنك ولم يرتض في صناعة رياضة تبلغه مبالغ الراسخين الأقدام في تلك الصناعة ولذلك قالوا في المثل :
( وابن اللبون إذا ما لز في قرن ... لم يستطع صولة البزل القناعيس )
هذا إن حملنا على حداثة السن وهو نص في ابن مسعود رضي الله عنه فإن حملناه على حدثان العهد بالصناعة ويحتمله قوله : [ وكان زعيم القوم أرذلهم ] وقوله : [ وساد القبيلة فاسقهم ] وقوله : [ إذا أسند الأمر إلى غير أهله ] فالمعنى فيها واحد فإن الحديث العهد بالشيء لا يبلغ مبالغ القديم العهد فيه
ولذلك يحكى عن الشيخ أبي مدين أنه سئل عن الأحداث الذين نهى شيوخ الصوفية عنهم فقال : الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعد وإن كان ابن ثمانين سنة
فإذا تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غيرهم ولذلك قال فيهم : [ سفهاء الأحلام ] وقال : [ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ] إلى آخره وهو منزل على الحديث الآخر في الخوارج :
[ إن من ضئضيء هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ] إلى آخر الحديث يعني أنهم لم يتفقهوا فيه فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم
وأما لعن آخر هذه الأمة أولها فظاهر مما ذكر العلماء عن بعض الفرق الضالة فإن الكاملية من الشيعة كفرت الصحابة رضي الله عنهم حين لم يصرفوا الخلافة إلى علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكفرت عليا رضي الله عنه حين لم يأخذ بحقه فيها
قا ل مصعب الزبيري و ابن نافع : دخل هارون ( يعني الرشيد ) المسجد فركع ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه و سلم فسلم عليه ثم أتى مجلس مالك فقال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ثم قال ل مالك : هل لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في الفيء حق ؟ قال : لا ! ولا كرامة ولا مسرة قال : من أين قلت ذلك ؟ قال : قال الله عز و جل : { ليغيظ بهم الكفار } فمن عابهم فهو كافر ولا حق لكافر في الفيء
واحتج مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى : { للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم } إلى آخر الآيات الثلاث قال : فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذين هاجروا معه وأنصاره { والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } فمن عدا هؤلاء فلا حق لهم فيه وفي فعل خواص الفرق من هذا المعنى كثير
وأما بعث الدجالين فقد كان ذلك جملة منهم من تقدم في زمان بني العباس وغيرهم ومنهم معد من العبيدية الذين ملكوا إفريقية فقد حكى عنه أنه جعل المؤذن يقول : أشهد أن معدا رسول الله عوضا من كلمة الحق أشهد أن محمدا رسول الله فهم المسلمون بقتله ثم رفعوه إلى معد ليروا هل هذا عن أمره ؟ فلما انتهى كلامهم إليه قال : أردد عليهم أذانهم لعنهم الله
ومن يدعي لنفسه العصمة فهو شبه من يدعي النبوة ومن يزعم أنه به قامت السموات والأرض فقد جاوز دعوى النبوة وهو المغربي المتسمي بالمهدي
وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له الفازازي ادعى النبوة واستظهر عليها بأمور موهمة للكرامات والإخبار بالمغيبات ومخيلة لخوارق العادات تبعه على ذلك من العوام جملة ولقد سمعت بعض طلبة ذلك البلد الذي اختله هذا البأس ـ وهو مالقة ـ آخذا ينظر في قوله تعالى : { وخاتم النبيين } وهل يمكن تأويله ؟ وجعل يطرق إليه الاحتمالات ليسوغ إمكان بعث نبي بعد محمد صلى الله عليه و سلم وكان مقتل هذا المفتري على يد شيخ شيوخنا أبي جعفر بن الزبير رحمه الله
ولقد حكى بعض مؤلفي الوقت قال : حدثني شيخنا أبو الحسن بن الجياب قال : لما أمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن الذي أخرج منه إلى مصرعه جهر بتلاوة سورة يس فقال أحد الذعرة ممن جمع السجن بينهما : اقرأ قرآنك لي شيء تنفصل على قرآننا اليوم ؟ أو في معنى هذا فتركها مثلا بلوذعيته
وأما مفارقة الجماعة فبدعتها ظاهرة ولذلك يجازي مفارقتها بالميتة الجاهلية
وقد ظهر في الخوارج وغيرهم ممن سلك مسلكهم كالعبيدية وأشباههم
فهذه ايضا من جملة ما اشتملت عليه تلك الأحاديث وباقي الخصال المذكورة عائد إلى نحو آخر ككثرة النساء وقلة الرجال وتطاول الناس في البنيان وتقارب الزمان
فالحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه و سلم من أنها تقع وتظهر وتنتشر أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي هي ليست ببدعة
وأن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا وبالله التوفيق
فصل فإن قيل : أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع
فإن قيل : أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حيث هو توقيت معلوم معقول فإيجابه أو إجازته بالرأي ـ كما تقدم من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجية عن الجادة ـ فظاهرومن ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي والقول بترك العمل بخبر الواحد وما أشبه ذلك
فالقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام فما كان منها هذا شأنه : هل يعد مثله بدعة أم لا ؟
فالجواب : أن مثل هذه المسألة لها نظران :
أحدهما : نظر من حيث وقوعها واعتقادا في الأصل فلا شك أنها مخالفة لا بدعة إذ ليس من شرط كون الممنوع والمكروه غير بدعة أن لا ينشرها ولا يظهرها أنه ليس من شرط أن تنشر بل لا تزول المخالفة ظهرت أو لا واشتهرت أم لا وكذلك دوام العمل أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما والمبتدع قد يقام عن بدعة والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى الموت عياذا بالله
والثاني : نظر من جهة ما يقترن بها من خارج فالقرائن قد تقترن فتكون سببا في مفسدة حالية وفي مفسدة مالية كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة
أما الحالية فبأمرين :
الأول : أن يعمل بها الخواص من الناس عموما وخاصة العلماء خصوصا وتظهر من جهتهم وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها لأن العالم المنتصب مفتيا للناس بعمله كما هو مفت بقوله فإذا نظر إليه الناس يعمل ما يأمر هو بمخالفته حصل في اعتقادهم جوازه ويقولون : لو كان ممنوعا أو مكروها لامتنع منه العالم
هذا وإن نص على منعه أو كراهته فإن عمله معارض لقوله فإما أن يقول العامي : إن العالم خالف بذلك ويجوز عليه مثل ذلك وهم عقلاء الناس وهم الأقلون
وإما أن يقول : إنه وجد فيه رخصة فإنه لو كان كما قال لم يأت به فيرجح بين قوله وفعله والفعل أغلب من القول في جهة التأسي ـ كما تبين في كتاب الموافقات ـ فيعمل العامي بعمل العالم تحسينا للظن به فيعتقده جائزا وهؤلاء هم الأكثرون
فقد صار عمل العالم عند العامي حجة كما كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في الفتيا فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل وهذا عين البدعة
بل لقد وقع مثل في طائفة ممن تميز عن العامة بانتصاب في رتبة العلماء فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات وقراءة الحزب حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة وأن منها ما هو حسن وكان منهم من ارتسم في طريقة التصوف فأجاز التعبد لله بالعبادات المبتدعة واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاة كما تقدم
ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا لمستند فوضعه في كتاب وجعله فقها كبعض أماريد الرس ممن قيد على الأمة ابن زيد
وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان والعمل به على الغفلة ومن هنا تسشنع زلة العالم فقد قالوا : ثلاث تهدم الدين : زلة العالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة ضالون
وكل ذلك عائد وباله على العالم وزلله المذكور عند العلماء يحتمل وجهين :
أحدهما : زلله في النظر حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة فيتابع عليه وذلك الفتيا بالقول
والثاني : من قسمي المفسدة الحالية أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر فلا ينكرها الخواص ولا يرفعون لها رؤوسهم وهم قادرون على الإنكار فلم يفعلوا فالعامي من شأنه إذا رأى أمرا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكرها عليه اعتقد أنه جائز وأنه حسن أو أنه مشروع بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد أنه عيب أو أنه غير مشروع أو أنه ليس من فعل المسلمين هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة لأن مستنده الخواص واعلماء في الجائز مع غير الجائز
فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجوده القدرة عليه فلم يفعل دل عند العوام على أنه فعل جائز لا حرج فيه فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يقنع بمثله من كان من العوام فصارت المخالفة بدعة كما في القسم الأول
وقد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه الصلاة و السلام والعلماء ورثة الأنبياء فكما أن النبي صلى الله عليه و سلم يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره كذلك وارثة يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره واعتبر ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهي عنها فلم ينكرها العلماء أو عملوا بها فصارت بعد سننا ومشروعات كزيادتهم مع الآذان : اصبح ولله الحمد و الوضوء للصلاة و تأهبوا ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع وربما احتجوا على ذلك بما يفعله بعض الناس وبما وضع في نوازل ابن سهل غفلة عما أخذ عليه فيه وقد قيدنا في ذلك جزءا مفردا فمن أراد الشفاء في المسألة فعليه به وبالله التوفيق
وخرج أبو داود عن [ أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال ] :
[ إهتم النبي صلى الله عليه و سلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل : انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك ـ قال ـ فذكر له القنع يعني الشبور وفي رواية شبور اليهود فلم يعجبه وقال : هو من أمر اليهود قال : فذكر له الناقوس فقال : هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأري الأذان في منامه ] إلى آخر الحديث
وفي مسلم عن أنس بن مالك أنه قال :
ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة والقنع والشبور ـ هو البوق ـ وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما
فأنت ترى كيف كره النبي صلى الله عليه و سلم شأن الكفار فلم يعمل على موافقته فكان ينبغي لمن اتسم بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاما بالأوقات أو غير إعلام بها أما الراية فقد وضعت إعلاما بالأوقات وذلك شائع في بلاد المغرب حتى إن الأذان معها قد صار في حكم التبع
وأما البوق فهو العلم في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار ثم هو علم أيضا بالمغرب والأندلس على وقت السحور ابتداء وانتهاء والحديث قد جعل علما لانتهاء نداء ابن أم مكتوم قال ابن شهاب : وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت
وفي مسلم و أبي داود :
[ لا يمنعن أحدكم نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ] الحديث فقد جعل أذان بلال لأن ينتبه النائم لما يحتاج إليه من سحوره وغيره فالبوق ما شأنه ؟ وقد كرهه عليه الصلاة و السلام ومثله النار التي ترفع دائما في أوقات الليل وبالعشاء والصبح في رمضان أيضا إعلاما بدخوله فتوقد في داخل المسجد ثم في وقت السحور ثم ترفع في المنار إعلاما بالوقت والنار شعار المجوس في الأصل
قال ابن العربي : أول من اتخذ البخور في المسجد بنو برمك يحيى بن خالد ومحمد بن خالد ـ ملكهما الوالي أمر الدين فكان محمد بن خالد حاجبا ويحيى وزيرا ثم ابنه جعفر بن يحيى ـ قال ـ وكانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة فأحيوا المجوسية واتخذوا البخور في المساجد ـ وإنما تطيب بالخلوق ـ فزادوا التجمير ويعمرونها بالنار منقولة حتى يجعلونها عند الأندلس ببخورها ثابتة انتهى
وحاصلة أن النار ليس إيقادها في المساجد من شأن السلف الصالح ولا كانت مما تزين بها المساجد البتة ثم أحدث التزيين بها حتى صارت من جملة ما يعظم به رمضان واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في المساجد حتى لقد سأل بعض عنه : أهو سنة أم لا ؟ ولا يشك أحد أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد وذلك بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم
وكذلك أيضا لما لم يتخذ الناقوس للإعلام حاول الشيطان فيه بمكيدة أخرى فعلق بالمساجد واعتد به في جملة الالآت التي توقد عليها النيران وتزخرف بها المساجد زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك كما تزخرف الكنائس والبيع
ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن ذكر النووي أنها من البدع القبيحة وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح منها إضاعة المال في غير وجهه ومنها إظهار شعائر المجوس ومنها اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة ومنها تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع ا هـ
وقد ذكر الطرطوشي في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور وذكر أيضا قبائح سواها فأين هذا كله من إنكار مالك لتنحنح المؤذن أو ضربه الباب ليعلم بالفجر أو وضع الرداء ؟ وهو أقرب مراما وأيسر خطبا من أن تنشأ بدع محدثات يعتقدها العوام سننا بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار وسبب عملهم بها
وأما المفسدة المالية فهي على فرض أن يكون الناس عاملين بحكم المخالفة وأنها قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورها ويدخل في الإسلام أحد ممن يراها شائعة ذائعة فيعتقدونها جائزة أو مشروعة لأن المخالفة إذا فشا في الناس فعلها من غير إنكار لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو الطاعات
وعندنا كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا فكل من يراهم من العامة صيارف وتجارا في أسواقنا من غير إنكار يعتقد أن ذلك جائز كذلك وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي المصنوع من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا بوزن ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا والصاغة عندنا كلهم أو غالبهم يتبايعون على ذلك أن يستفضلوا قيمة الصياغة أو إجارتها ويعتقدون أن ذلك جائز لهم ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من أمثال هذه الأشياء حتى كانوا يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام أمرا هو أشد من ترك السنن وأولى أن يتركوا المباحات أن لا يعتقد فيها أمر ليس بمشروع وقد مر بيان هذا في باب البيان من كتاب الموافقات فقد ذكروا أن عثمان رضي الله عنه كان لا يقصر في السفر فيقال له : أليس قد قصرت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فيقول : بلى ولكني إمام الناس فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين فيقولون : هكذا فرضت
قال الطرطوشي : تأملوا رحمكم الله ! فإن في القصر قولين لأهل الإسلام :
منهم من يقول : فريضة ومن أتم فإنما يتم ويعيد أبدا
ومنهم من يقول : سنة يعيد من أتم في الوقت ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة لما خاف من سوء العاقبة أن يعتقد الناس أن الفرض ركعتان
وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يضحون ( يعني أنهم لا يلتزمون الأضحية )
قال حذيفة بن أسد : شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة
وقال بلال : لا أبالي أن أضحي بكبشين أو بديك
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يشتري لحما بدرهم يوم الأضحى ويقول لعكرمة : من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس
وقال ابن مسعود : إني لأترك أضحيتي ـ وإني لمن أيسركم ـ مخافة أن يظن أنها واجبة
وقال طاوس : ما رأيت بيتا أكثر لحما وخبزا وعلما من بيت ابن عباس يذبح وينحر كل يوم ثم لا يذبح يوم العيد وإنما يفعل ذلك لئلا يظن الناس أنها واجبة وكان إماما يقتدى به
قال الطرطوشي : والقول في هذا كالذي قبله وإن لأهل الإسلام قولين في الأضحية أحدهما سنة والثاني واجبة ثم اقتحمت الصحابة ترك السنة حذرا من أن يضع الناس الأمر على غير وجهة فيعتقدونها فريضة
قال مالك في الموطأ في صيام ستة بعد الفطر من رمضان : إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ـ قال ـ ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة من أهل العلم ورأوهم يقولون ذلك
فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كما توهم بعضهم بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه لكنه لم ير العمل عليه وإن كان مستحبا في الأصل لئلا يكون ذريعة لما قال كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الأضحية وعثمان في الإتمام في السفر
وحكى الماوردي ما هو أغرب من هذا وإن كان الأصل فذكر أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الطرقة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب لأنه كان مفروشا فأمر زياد بإلقاء الحصا في صحن المسجد وقال : لست آمن من أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة وهذا في مباح فكيف به في المكروه أو الممنوع ؟
ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام أنه قال في الخمر : ليست بحرام ولا عيب فيها وإنما العيب أن يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه
وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الإسلام كان كفرا لأنه إنكار لما علم من دين الأمة ضرورة وبسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربها والتخلية بينهم وبين اقتنائها وشهرته بحارة أهل الذمة فيها وأشباه ذلك
ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع وهذا الحال متوقع أو واقع فقد حكى القرافي عن العجم ما يقتضي أن الستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان لإبقائهم حالة رمضان الخاصة به كما هي إلى تمام الستة الأيام وكذلك وقع عندنا مثله وقد مر في الباب الأول
وجميع هذا منوط إثمه بمن يترك الإنكار من العلماء أو غيرهم أو من يعمل ببعضها بمرآى من الناس أو في مواقعهم فإنهم الأصل في انتشار هذه الاعتقادات في المعاصي أو غيرها
وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه
وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجهأحدها : وهو أظهر الأقسام ـ أن يخترعها المبتدع
والثاني : أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة
والثالث : أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار وهو قادر عليه فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة
والرابع : من باب الذرائع وهي أن يكون العمل في أصله معروفا إلا أنه يبتدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى
إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحد ولا يقع اسم البدعة عليها بالتواطؤ بل هي في القرب والبعد على تفاوت فالأول هو الحقيق باسم البدعة فإنها تؤخذ علة بالنص عليها ويليه القسم الثاني فإن العمل يشبهه التنصيص بالقول بل قد يكون أبلغ منه في مواضع ـ كما تبين في الأصول ـ غير أنه لا ينزل ها هنا من كل وجه منزلة الدليل أن العالم قد يعمل وينص على قبح عمله ولذلك قالوا : لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله بصدقك وقال الخليل بن أحمد أو غيره :
( اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ... ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري )
ويليه القسم الثالث فإن ترك الإنكار ـ مع أن رتبة المنكر رتبة من بعد ذلك منه إقرارا ـ يقتضي أن الفعل غير منكر ولكن يتنزل منزلة ما قبله لأن الصوارف للقدرة
كثيرة قد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونه مخالفة
ويليه القسم الرابع لأن المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالعرض فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تساوي رتبة الواقعة أصلا فلذلك كانت من باب الذرائع فهي إذا لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة
وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات والبدعة من خارج إلا أنها لازمة لزوما عاديا ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث والله أعلم
الباب الثامن : في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والإستحسان
هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة فإن كثيرا من الناس عدوا أكثر المصالح المرسلة بدعا ونسبوها إلى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات وقم جعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام الشريعة فقالوا : إن منها ما هو واجب ومندوب وعدوا من الواجب كتب المصحف وغيره ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضام على قارىء واحدوأيضا فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص ولا كونه قياسا بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة فإنها راجعة إلى أمور في الدين مصلحية ـ في زعم واضعيها ـ في الشرع على الخصوص
وإذا ثبت هذا فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقا فاعتبار البدع المستحسنة حق لأنهما يجريان من واد واحد وإن لم يكن اعتبار البدع حقا لم يصح اعتبار المصالح المرسلة
وأيضا فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقا عليه بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين إلى رده وأن المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل وذهب مالك إلى اعتبار ذلك وبنى الأحكام عليه على الإطلاق وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح لكن يشرط قربه من معاني الأصول الثابتة هذا ما حكى الإمام الجويني
وذهب الغزالي إلى أن المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معين وإن وقع في رتبة الضروري فميله إلى قبوله لكن بشرط قال : ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد واختلف قوله في الرتبة المتوسطة وهي رتبة الحاجي فرده في المستصفى وهو آخر قوليه وقبله في شفاء العليل كما قل ما قبله وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله فالأقوال خمسة فإذا الراد لاعتبارها لا يبقى له في الوقائع الصحابية مستند إلا أنها بدعة مستحسنة ـ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاجتماع لقيام رمضان : نعمت البدعة هذه ـ إذ لا يمكنهم ردها لإجتماعهم عليها
وكذلك القول في الاستحسان فإنه على ما ذهب إليه المتقدمون راجع إلى الحكم بغير دليل والنافي له لا يعد الاستحسان سببا فلا يعتبر في الأحكام البتة فصار كالمصالح المرسلة إذا قيل بردها
فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته كان الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء حتى يتبين أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدر بحول الله والله الموفق فنقول :
المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يشهد الشرع بقبوله فلا إشكال في صحته ولا خلاف في أعماله وإلا كان مناقضة للشريعة كشريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغيرها
والثاني : ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله إذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسها وإنما ذلك مذهب أهل التسحين العقلي بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام فحينئذ نقبله فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل يرده كان مردودا باتفاق المسلمين
ومثال ما حكى الغزالي عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على بعض السلاطين فسأله عن الوقاع في نهار رمضان فقال : عليك صيام شهرين متتابعين فلما خرج راجعه بعض الفقهاء وقالوا له : القادر على اعتاق الرقبة كيف يعدل له إلى الصوم والصوم وظيفة المعسرين وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين ؟ فقال لهم : لو قلت له عليك إعتاق رقبة لا ستحقر ذلك وأعتق عبيدا مرارا فلا يزجره إعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين
فهذا المعنى مناسب لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر والملك لا يزجره الإعتاق ويزجره الصيام وهذه الفتيا باطلة لأن العلماء بين قائلين : قائل بالتخيير وقائل بالترتيب فيقدم العتق على الصيام فتقديم الصيام بالنسبة إلى الغني لا قائل به على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه هذا لكنه على صريح الفقه
قال يحيى بن بكير : حنث الرشيد في يمين فجمع العلماء فأجمعوا أن عليه عتق رقبة فسأل مالكا فقال : صيام ثلاثة أيام واتبعه على ذلك إسحاق بن إبراهيم من فقهاء قرطبة
حكى ابن بشكوال أن الحكم أمير المؤمنين أرسل في الفقهاء وشاورهم في مسألة نزلت به فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى إحدى كرائمه ووطئها في رمضان فأفتوا بالإطعام و إسحاق بن إبرهيم ساكت فقال له أمير المؤمنين : ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه ؟ فقال له : لا أقول بقولهم وأقول بالصيام فقيل له : أليس مذهب مالك الإطعام ؟ فقال لهم : تحفظون مذهب مالك إلا أنكم تريدون مصانعة أمير المؤمنين إنما أمر بالإطعام لمن له مال وأمير المؤمنين لا مال له إنما هو مال بيت المسلمين فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكر له عليه ا هـ وهذا صحيح
نعم حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته فقال يحيى بن يحيى : يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده فقالوا ليحيى : ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والطعام والصيام ؟ فقال لهم : لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود
فإن صح هذا عن يحيى بن يحيى رحمه الله وكان كلامه على ظاهره كان مخالفا للإجماع
والثالث : ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه فهذا على وجهين :
أحدهما : أن يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القتل للميراث فالمعاملة بنقيض المقصود تقدير إن لم يرد نص على وفقه فإن هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا بملائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر فلا يصح التعليل بها ولا بناء الحكم عليها باتفاق ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله
والثاني : أن يلائم تصرفات الشرع وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتبين وجهه بحول الله
ولنقتصر على عشرة أمثلة :
ولنقتصر على عشر أمثلة للمصالح المرسلة أحدها : أن أصحاب رسول الله صلى
الله عليه و سلم اتفقوا على جمع المصحفأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم اتفقوا على جمع المصحف وليس ثم نص على جمعه وكتبه أيضا بل قد قال بعضهم : كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ارسل إلي أبو بكر رضي الله عنه [ بعد ] مقتل ( أهل ) اليمامة وإذا عنده عمر رضي الله عنه قال أبو بكر : ( إن عمر أتاني فقال ) : إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قال : فقلت له : كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال لي : هو ـ والله ـ خير
فلم يزل عمر يراجعني في لذك حتى شرح الله صدري له ورأيت فيه الذي رأى عمر
قال زيد فقال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتتبع القرآن فاجمعه قال زيد : فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك فقلت : كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال أبو بكر : هو والله خير فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح صدريهما فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاق والعسب واللخاف ومن صدور الرجال فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة
ثم روي عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام وأهل العراق في فتح أرمينية وأذربيجان فأفزعه اختلافهم في القرآن فقال لعثمان : يا أمير المؤمنين ! أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة : أرسلي إلي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها عليك فأرسلت حفصة بها إلى عثمان فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وغلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة : ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم
قال : ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق
فهذا أيضا إجماع آخر في كتبه وجمع الناس على قراءة لم يحصل منها في الغالب اختلاف لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات ـ حسبما نقله العلماء المعتنون بهذا الشأن ـ فلم يخالف في المسألة إلا عبد الله بن مسعود فإنه امتنع من طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصاحف عثمان وقال : يا أهل العراق ! ويا أهل الكوفة : اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها فإن الله يقول : { ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } وألقوا إليه بالمصاحف فتأمل كلامه فإنه لم يخالف في جمعه وإنما خالف أمرا آخر ومع ذلك فقد قال ابن هشام : بلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم
ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه و سلم بما صنعوا من ذلك ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم وإلى منع الذريعة للإختلاف في أصلها الذي هو القرآن وقد علم النهي عن الإختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه
وإذا استقام هذا الأصل فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا خيف عليها الاندراس زيادة على ما جاء في الأحاديث من الأمر بكتب العلم
وأنا أرجو أن يكون كتب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مغفلا جدا إلا من النقل الجلي كما نقل ابن وضاح أو يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كما ينبغي ولم أجد على شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشي وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه وإلا ما وضع الناس في الفرق الثنتين والسبعين وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه فأخذت نفسي بالعناء فيه عسى أن ينتفع به واضعه وقارئه وناشره وكاتبه والمنتفع به وجميع المسلمين إنه ولي ذلك ومسديه بسعة رحمته
المثال الثاني : اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على حد شارب الخمر
اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على حد شارب الخمر ثمانين وإنما مستندهم فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال المرسل قال العلماء : لم يكن فيه في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم حد مقدر وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزير ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه قرره على طريق النظر بأربعين ثم انتهى الأمر إلى عثمان رضي الله عنه فتتابع الناس فجمع الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم فقال علي رضي الله عنه : من سكر هذى ومن هذى افترى فأرى عليه حد المفتري
ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل أن الصحابة أو الشرع يقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات والمظنة مقام الحكمة فقد جعل الإيلاج في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال وجعل الحافر للبئر في محل العدوان وإن لم يكن ثم مرد كالمردي نفسه وحرم الخلوة بالأجنبية حذرا من الذريعة إلى الفساد إلى غير ذلك من الفساد فرأوا الشرب ذريعة إلى الإفتراء الذي تقتضيه كثرة الهذيان فإنه أول سابق إلى السكران ـ قالوا ـ فهذا من أوضح الأدلة على إسناد الأحكام إلى المعاني التي لا أصول لها ( يعني على الخصوص به ) وهو مقطوع من الصحابة رضي الله عنهم
المثال الثالث : إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع
إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع قال علي رضي الله عنه : لا يصلح الناس إلا ذاك ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين : إما ترك الاستصناع بالكلية وذلك شاق على الخلق وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ضلك بدعواهم الهلاك والضياع فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة فكانت المصلحة التضمينهذا معنى قوله : لا يصلح الناس إلا ذاك
ولا يقال : إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء إذ لعله ما أفسده ولا فرط فالتضمين مع ذلك كان نوعا من الفساد لأنا نقول : إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت ووقع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد والغالب الفوت فوت الأموال وأنها لا تستند إلى التلف السماوي بل ترجع إلى صنع العباد على المباشرة أو التفريط
وفي الحديث :
[ لا ضرر ولا ضرار ] تشهد له الأصول من حيث الجملة فإن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن أن يبيع حاضر لباد وقال :
[ دع الناس يرزف الله بعضهم من بعض ] وقال : [ لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق ] وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فتضمين الصناع من ذلك القبيل
المثال الرابع : أن العلماء اختلفوا في الضرب بآلتهم
إن العلماء اختلفوا في الضرب بآلتهم وذهب مالك إلى جواز السجن في التهم وإن كان السجن نوعا من العذاب ونص أصحابه على جواز الضرب وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السراق والغصاب إذ قد يتعذر إقامة البينة فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين والإقرارفإن قيل : هذا فتح باب التعذيب البريء قيل : ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال بل الإضراب عن التعذيب أشد ضررا إذ لا يعذب أحد لمجرد الدعوى بل مع اقتران قرينة تحيك في النفس وتؤثر في القلب نوعا من الظن فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريء وإن أمكن مصادفته فتغتفر كما اغتفرت في تضمين الصناع
فإن قيل : لا فائدة في الضرب وهو لو أقر لم يقبل إقراره في تلك الحال فالجواب :
إحداهما : أن يعين المتاع فتشهد عليه البينة لربه وهي فائدة ظاهرة
والثانية : أن غيره قد يزدجر حتى لا يكثر الإقدام فتقل أنواع هذا الفساد
وقد عد له سحنون فائدة ثالثة وهو الإقرار حالة التعذيب بأنه يؤخذ عنده بما أقر في تلك الحال قالوا : وهو ضعيف فقد قال الله تعالى : { لا إكراه في الدين } ولكن نزله سحنون على من أكره بطريق غير مشروع كما إذا أكره على طلاق زوجته أما إذا أكره بطريق صحيح فإنه يؤخذ به فالكافر يسلم تحت ظلال السيوف فإنه مأخؤذ به وقد تتفق له بهذه الفائدة على مذهب غير سحنون إذا أقر حالة التعذيب ثم تمادى على الإقرار بعد أمنه فيؤخذ به
قال الغزالي بعد ما حكى عن الشافعي : أنه لا يقول بذلك وعلى الجملة فالمسألة في محل الإجتهاد ـ قال ـ ولسنا نحكم بمذهب مالك على القطع فإذا وقع النظر في تعارض المصالح كان ذلك قريبا من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة
المثال الخامس : إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود
إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار وخلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال بيت المال ثم إليه النظر في توظيف وذلك على الغلات والثمار وغير ذلك كيلا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب وذلك يقع قليلا من كثير بحيث لا يحجف بأحد ولا يحصل المقصودوإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا فإن القضية فيه أحرى ووجه المصلحة هنا ظاهر فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلب شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار
وإنما النظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله فالذين يحذرون من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير منها فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم يأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد
والملائمة الأخرى أن الأب في طفله أن الوصي في يتيمه أو الكافل فيمن يكفله مأمور برعاية الأصلح له وهو يصرف ماله إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج إليها وكل ما يراه سببا لزيادة ماله أو حراسته من التلف جاز له بذل المال في تحصيله ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة طفل ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق محجوره
ولو وطىء الكفار أرض الإسلام لوجب القيام بالنصرة وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة وفيه إتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة زيادة إلى إنفاق المال وليس ذلك إلا لحماية الدين ومصلحة المسلمين
فإذا قدرنا هجومهم واستشعر الكفار الذين يخاف من جهتهم فلا يؤمن من انفتاح باب الفتن بين المسلمين فالمسألة على حالها كما كانت وتوقع الفساد عتيد فلا بد من الحراس
فإذا قدرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم فلا يؤمن من انفتاج باب الفتن بين المسلمين فالمسألة على حالها كما كانت وتوقع الفساد عتيد فلا بد من الحراس
فهذه ملائمة صحيحة إلا أنها في محل ضرورة فتقدر بقدرها فلا يصح هذا الحكم إلا مع وجودها والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجي وأما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحديث لا يغني كبير شيء فلا بد من جريان حكم التوظيف
وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه وتلاه في صحيحها ابن العربي في أحكام القرآن له وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع
المثال السادس : أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال
إن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات فاختلف العلماء في ذلك حسبما ذكره الغزالي على أن الطحاوي حكى أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ فأجمع العلماء على منعهفأما الغزالي فزعم أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد به في الإسلام ولا يلائم تصرفات الشرع مع هذه العقوبة الخاصة لم تتعين لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب وغيرهما ـ قال ـ فإن قيل : فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خالد ين الوليد في ماله حتى أخذ رسوله فرد نعله وشطر عمامته قلنا : المظنون من عمر أنه لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع وإنما ذلك لعلم عمر باختلاط ماله بالمال المستفاد من الولاية وإحاطته بتوسعته فلعله ضمن المال فرآى شطر ماله من فوائد الولاية فيكون استرجاعا للحق لا عقوبة في المال لأن هذا من الغريب الذي لا يلائم قواعد الشرع هذا ما قال ولما فعل عمر وجه آخر غير هذا ولكنه لا دليل فيه على العقوبة بالمال كما قال الغزالي
وأما مذهب مالك فإن العقوبة في المال عنده ضربان :
أحدهما : كما صوره الغزالي فلا مرية في أنه غير صحيح على أن ابن العطار في رقائقه صغى إلى إجازة ذلك فقال : في إجازة أعوان القاضي إذا لم يكن بيت مال أنها على الطالب فإن أدى المطلوب كانت الإجازة عليه ومال إليه ابن رشد ورده عليه ابن النجار القرطبي وقال : إن ذلك من باب العقوبة في المال وذلك لا يجوز على حال
والثاني : أن تكون جناية في نفس ذلك المال أو في عوضه فالعقوبة فيه عنده ثابتة فإنه قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه : إنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر
وذهب ابن القاسم و مطرف و ابن الماجشون إلى أنه يتصدق بما قل منه دون ما كثر وذلك محكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه أراق اللبن المغشوش بالماء ووجه ذلك التأديب للغاش وهذا التأديب لا نص يشهد له لكن من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين الصناع
على أن أبا الحسن اللخمي قد وضع له أصلا شرعيا وذلك :
أنه عليه الصلاة و السلام أمر بإكفاء القدور التي أغليت بلحوم الحمر قبل أن تقسم
وحديث العتق بالمثلة أيضا من ذلك
ومن مسائل مالك في المسألة : إذا اشترى مسلم من نصراني خمرا فإنه يكسر على المسلم ويتصدق بالثمن أدبا للنصراني إن كان النصراني لم يقبضه وعلى هذا المعنى فرع أصحابه في مذهبه وهو كله من العقوبة في المال إلا أن وجهة ما تقدم
المثال السابع : أنه إذا طبق الحرام الأرض
أنه لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها وانسدت طرق المكاسب الطيبة ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة ويرتقي إلى قدر الحاجة في القوت والملبس والمسكن إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال ولم يزال الناس في مقاسات ذلك إلى أن يهلكوا وفي ذلك خراب الدين ولكنه لا ينتهي إلى الترفه والتنعم كما لا يقتصر على مقدار الضرورةوهذا ملائم لتصرفات الشرع وإن لم ينص على عينه فإنه قد أجاز أكل الميتة للمضطر والدم ولحم الخنزير وغير ذلك من الخبائث المحرمات
وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة وإنما اختلفوا إذا لم تتوال هل يجوز له الشبع أم لا ؟ وايضا فقد أجاوزا أخذ مال الغير عند الضرورة أيضا فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك
وقد بسط الغزالي هذه المسألة في الإحياء بسطا شافيا جدا وذكرها في كتبه الأصولية كـ المنخول و شفاء العليل
المثال الثامن : أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد
أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد والمستند فيه المصلحة المرسلة إذ لا نص على عين المسألة ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب مالك و الشافعي ووجه المصلحة أن القتيل معصوم وقد قتل عمدا فإهداره داع أنه إلى خرم أصل القصاص واتخاذ الإستعانة والإشتراك ذريعة إلى السعي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقا والمشترك ليس بقاتل تحقيقافإن قيل : هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل : قلنا : ليس كذلك بل لم يقتل إلا القاتل وهم الجماعة من حيث الاجتماع عند مالك و الشافعي فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة وقطع الأيدي في النصاب الواجب
المثال التاسع : أن العلماء نقلوا الإتفاق على أن الإمامة الكبرى لا
تنعقدإلا لمن نال رتبة الإجتهادإن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الإجتهاد والفتوى في علوم الشرع كما أنهم اتفقوا أيضا ـ أو كادوا أن يتفقوا ـ على أن القضاة بين الناس لا يحصل إلا لمن رقي في رتبة الإجتهاد وهذا صحيح على الجملة ولكن إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس وافتقروا إلى إمام يقدمونه لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم فلا بد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد لأنا بين أمرين إما أن يترك الناس فوضى وهو عين الفساد والهرج وإما أن يقدموه فيزول الفساد بتة ولا يبقى إلا فوت الإجتهاد والتقليد كاف بحسبه وإذا ثبت هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة وهو مقطوع به بحيث لا يفتقر في صحته وملائمته إلى شاهد
هذا وإن كان ظاهره مخالفا لما نقلوا من الإجماع في الحقيقة إنما انعقد على فرض أن لا يخلو الزمان من مجتهد فصار مثل هذه المسألة مما لم ينص عليه فصح الإعتماد فيه على المصلحة
المثال العاشر : أن الغزالي قال ببيعة المفضول مع وجود الأفضل
إن الغزالي قال في بيعة المفضول مع وجود الأفضل : إن رددنا في مبدأ التولية بين مجتهد في علوم الشرائع وبين متقاصر عنها فيتعين تقديم المجتهد لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية على اتباع علم غيره فالتقليد والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتهاأما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد المنفك عن رتبة الإجتهاد وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بأن خلا الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشرائط وجب الإستمرار
وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للفروع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرضه لإثارة فتن واضطراب أمور لم يجز لهم خلعه والإستبدال به بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته لأنا نعلم أن العلم مزية روعيت الإمامة تحصيلا لمزيد المصلحة في الإستقلال بالنظر والإستغناء عن التقليد وأن الثمرة المطلوبة من الإمام تطفئه الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في الحال ؟ تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد
قال : وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق من الضرر بسبب عدول الإمام عن النظر إلى التقليد بما ينالهم لو تعرضوا لخلعه والإستبدال به أو حكموا بأن إمامته غير منعقدة
هذا ما قال وهو متجه بحسب النظر المصلحي وهو ملائم لتصرفات الشرع وإن لم يعضده نص على التعيين
وما قرره هو أصل مذهب مالك : قيل ليحيى بن يحيى : البيعة مكروهة ؟ قال : لا قيل له : فإن كانوا أئمة جور ؟ فقال : قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه
قال يحيى : والبيعة خير من الفرقة
قال : ولقد أتى مالكا العمري فقال له : يا أبا عبد الله بايعني أهل الحرمين وأنت ترى سيرة أبي جعفر فما ترى ؟ فقال له مالك : أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز أن يولي رجلا صالحا ؟ فقال العمري : لا أدري قال مالك لكني أنا أدري إنما كانت البيعة ليزيد بعده فخاف عمر إن ولى رجلا صالحا أن يكون ليزيد بد من القيام فتقوم هجمة فيفسد ما لا يصلح فصدر رأي هذا العمري على رأي مالك
فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح فالمصلحة في الترك
وروى البخاري عن نافع قال : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
[ ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ] وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه
قال ابن العربي : وقد قال ابن الخياط : إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها وأين يزيد من من ابن عمر ؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى فخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه تعرض للفتنة فكيف ولا يعلم ذلك ؟ وهذا أصل عظيم فتفقهوه والزموه ترشدوا إن شاء الله
فصل فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة
فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة وتبين لك اعتبار أمور :أحدها : الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله
والثاني : أن عامة النظر فيها إنما هو فيما غفل منها وجرى على دون المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل كالوضوء والصلاة في زمان مخصوص دون غيره والحج ونحو ذلك
فيتأمل الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المخص المنافي للمناسبات التفصيلية
ألا ترى أن الطهارات ـ على اختلاف أنواعها ـ قد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف جدا لما يظهر لبادي الرأي ؟ فإن البول والغائط خارجان نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء دون المخرجين فقط ودون جميع الجسد فإذا خرج المني أو دم الحيض وجب غسل جميع الجسد دون المخرج فقط ودون أعضاء الوضوء
ثم إن التطهير واجب مع نظافة الأعضاء وغير واجب مع قذارتها بالأوساخ والأدران إذا فرض أنه لم يحدث
ثم التراب ـ ومن شأنه التلويث ـ يقوم مقام الماء الذي من شأنه التنظيف
ثم نظرنا في أوقات الصلوات فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات فيها لاستواء الأوقات في ذلك
وشرع للإعلام بها أذكار مخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص منها فإذا أقيمت ابتدأت إقامتها بأذكار أيضا ثم شرعت ركعاتها مختلفة باختلاف الأوقات وكل ركعة لها ركوع واحد وسجودان دون العكس إلا صلاة خسوف الشمس فإنها على غير ذلك ثم كانت خمس صلوات دون أربع أو ست وغير ذلك من الأعداد فإذا دخل المتطهر المسجد أمر بتحيته بركعتين دون واحدة كالموتر أو أربع كالظهر فإذا سها في صلاة سجد سجدتين دون سجدة واحدة وإذا قرأ آية سجدة سجد واحدة دون اثنتين
ثم أمر بصلاة النوافل ونهى عن الصلاة في أوقات مخصوصة وعلل النهي بأمر غير معقول المعنى
ثم شرعت الجماعة في بعض النوافل كالعيدين والخسوف والاستسقاء دون صلاة الليل ورواتب النوافل
فإذا صرنا إلى غسل الميت وجدناه لا معنى له معقولا فإنه غير مكلف ثم أمرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد والتكبير أربع تكبيرات دون اثنتين أو ست أو سبع أو غيرها من الأعداد
فإذا صرنا إلى الصيام وجدنا فيه من التعبدات غير المعقولة كثيرا كإمساك النهار دون الليل والإمساك عن المأكولات والمشروبات دون الملبوسات والمركوبات والنظر والمشي والكلام وأشباه ذلك وكان الجماع ـ وهو راجع إلى الإخراج ـ كالمأكول ـ وهو راجع إلى الضد وكان شهر رمضان ـ وإن كان قد أنزل فيه القرآن ـ ولم يكن أيام الجمع وإن كانت خير أيام طلعت عليها الشمس أو كان الصيام أكثر من شهر أو أقل ثم الحج أكثر تعبدا من الجميع
وهكذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه ما عملوا ( ؟ ) إن في هذا الاستقراء معنى يعلم من مقاصد الشرع أنه قصد قصده ونحى نحوه واعتبرت جهته وهو أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل فإن قصد الشارع أن يوقف عنده ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملة وأن يوكل إلى واضعه ويسلم له فيه وسواء علينا أقلنا : إن التكاليف معللة بمصالح العباد أم لم نقله : اللهم إلا قليلا من مسائلها ظهر فيها معنى فهمناه من الشرع فاعتبرنا به أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه فلا حرج حينئذ فإن أشكل الأمر فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل فهو العروة الوثقى للمتفقه في لاشريعة والوزر الأحمى
ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه : كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم ونحوه لابن مسعود أيضا وقد تقدم من ذلك كثير
ولذلك التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وإن ظهرت لبادي الرأي وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم على ما هي عليه فلم يلتفت في إزالة الأخباث ورفع الأحداث إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره حتى اشترط في رفع الأحداث النية ولم يقم غير الماء مقامه عنده ـ وإن حصلت النظافة ـ حتى يكون بالماء المطلق وامتنع من إقامة التكبير والقراءة بالعربية مقامها في التحريم والتحليل والإجزاء ومنع من إخراج القيم في الزكاة واختصر في الكفارات على مراعاة العدد وما أشبه ذلك
ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما حده الشارع دون ما يقتضيه معنى مناسب ـ إن تصور ـ لقلة ذلك في التعبدات وندوره بخلاف قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول فإنه استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية نعم مع مراعاة مقصود الشارع أن لا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من أصوله حتى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة وفتح باب التشريع وهيهات ما أبعده من ذلك ! رحمه الله بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتباع بحيث يخيل لبعض أنه مقلد لمن قبله بل هو صاحب البصيرة في دين الله ـ حسبما بين أصحابه في كتاب سيره ـ
بل حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال : إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع وهذه غاية في الشهادة بالاتباع
وقال أبو داود : أخشى عليه البدعة ( يعني المبغض ل مالك )
وقال ابن المهدي : إذا رأيت الحجازي يحب مالك بن أنس فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيت أحدا يتناوله فاعلم أنه على خلاف السنة
وقال إبراهيم بن يحيى بن هشام : ما سمعت ابا داود لعن أحدا قط إلا رجلين : أحدهما : رجل ذكر له أنه لعن مالكا والآخر : بشر المريسي
وعلى الجملة فغير مالك أيضا موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى وإن اختلفوا في بعض التفاصيل فالأصل متفق عليه عند الأمة ما عدا الظاهرية فإنهم لا يفرقون بين العبادات والعادات بل الكل غير معقول المعنى فهم أحرى بأن لا يقولوا بأصل المصالح فضلا عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة
والثالث : أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين وأيضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهي إذا من الوسائل لا من المقاصد ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد
أما رجوعها إلى ضروري فقد ظهر من الأمثلة المذكورة
وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم وهو إما لاحق بالضروري وإما من الحاجي وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إلى التقبيح والتزيين البتة فإن جاء من ذلك شيء : فإما من باب آخر منها كقيام رمضان في المساجد جماعة ـ حسبما تقدم ـ وإما معدود من قبيل البدع التي أنكرها السلف الصالح ـ كزخرفة المساجد والتثويب بالصلاة ـ وهو من قبيل ما يلائم
وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل و ما لا يتم الواجب إلا به إن نص على اشتراطه فهو شرط شرعي فلا مدخل له في هذا الباب لأن نص الشارع فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه
وإن لم ينص على اشتراطه فهو إما عقلي أو عادي فلا يلزم أن يكون شرعيا كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة فإنا لو فرضنا حفظ القرآن والعلم بغير كتب مطردا لصح ذلك وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا حفظها كما أنا لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا حفظها كما أنا لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك وكذلك سائر المصالح الضرورية ـ إذا ثبت هذا ـ لم يصح أن يستنبط من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل
وأما كونها في الحاجي من باب التخفيف فظاهر أيضا وهو أقوى في الدليل الرافع للحرج فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف والأمثلة مبينة لهذا الأصل أيضا
إذا تقررت هذه الشروط علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل والتعبدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق
وأيضا فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع بل إنما تتصور على أحد وجهين : إما منقاضة لمقصوده ـ كما تقدم في مسألة المفتي بصيام شهرين متتابعين ـ وإما مسكوتا عنه فيه كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به
وقد تقدم نقل الإجماع على اطراح القسمين وعدم اعتبارهما ولا يقال : إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم الملاءمة ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن المسكوت عنه كالمأذون فيه إن قيل بذلك فهي تفارقها إذ لا يقدم على استنباط عبادة لا أصل لها لأنها مخصوصة بحكم الإذن المصرح به بخلاف العادات والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في الجملة وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب الموافقات وإلى هذا
فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات لأن البدع من باب الوسائل لأنها متعبد بها بالفرض ولأنها زيادة في التكليف وهو مضادة للتخفيف
فحصل من هذا كله أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغى باتفاق العلماء وحسبك به متعلقا والله الموفق
وبذلك كله يعلم من قصد الشارع أنه لم يكل شيئا من التعبدات إلى آراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عند ما حده والزيادة عليه بدعة كما أن النقصان منه بدعة وقد مر لهما أمثلة كثيرة وسيأتي أخيرا في إثناء الكتاب بحول الله
فصل : وأما الإستحسان فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به
وأما الاستحسان فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به فإن الاستحسان لا يكون إلا بمستحسن وهو إما العقل أو الشرعأما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما لأن الأدلة اقتضت ذلك فلا فائدة لتسميته استحسانا ولا لوضع ترجمة له زائدة على الكتاب والسنة والإجماع وما ينشأ عنها من القياس والاستدلال فلم يبق إلا العقل هو المستحسن فإن كان بدليل فلا فائدة لهذه التسمية لرجوعه إلى الأدلة لا إلى غيرها وإن كان بغير دليل فذلك هو البدعة التي تستحسن
ويشهد لذلك قول من قال في الاستحسان : إنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه قالوا : وهو عند هؤلاء من جنس ما يستحسن في العوائد وتميل إليه الطباع فيجوز الحكم بمقتضاه إذا لم يوجد في الشرع ما ينافي هذا الكلام ما بين أن ثم من التعبدات ما لا يكون عليه دليل وهو الذي سمى بالبدعة فلا بد أن ينقسم إلى حسن وقبيح إذ ليس كل استحسان حقا
وأيضا فقد يجري على التأويل الثاني للأصوليين في الاستحسان وهو أن المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إظهاره وهذا التأويل فالاستحسان لبعده في مجاري العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل ينقدح له بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي لكن قد يمكنه إظهاره وقد لا يمكنه ـ وهو الأغلب ـ فهذا مما يحتجون به
وربما ينقدح لهذا المعنى وجه بالأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأولون وقد أتو بثلاثة أدلة :
أحدها : قول الله سبحانه : { واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم } وقوله تعالى : { الله نزل أحسن الحديث } وقوله تعالى : { فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه } هو ما تستحسنه عقولهم
والثاني : قوله عليه الصلاة و السلام :
[ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ] وإنما يعني بذلك ما رأوه بعقولهم وإلا لو كان حسنة بالدليل الشرعي لم يكن من حسن ما يرون إذ لا مجال للعقول في التشريع على ما زعمتم فلم يكن للحديث فائدة فدل على أن المراد ما رأوه برأيهم
والثالث : أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل ولا سبب لذلك إلا ان المشاحة في مثله قبيحة في العادة فاستحسن الناس تركه مع أنا نقطع أن الإجارة المجهولة أو مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا جهل فإنه ممنوع وقد استحسنت إجارته مع مخالفة الدليل فأولى أن يجوز إذا لم يخالف دليلا
فأنت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم أيضا لمن أراد أن يبتدع فله أن يقول : إن استحسنت كذا وكذا فغيري من العلماء استحسن وإذا كان كذلك فلا بد من فضل اعتناء بهذا الفصل حتى لا يغتر به جاهل أو زاعم أنه عالم وبالله التوفيق فنقول :
إن الاستحسان يراه معتبرا في الأحكام مالك و أبو حنيفة بخلاف الشافعي فإنه منكر له جدا حتى قال : من استحسن فقد شرع والذي يستقرىء من مذهبها أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين هكذا قال ابن العربي ـ قال ـ فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطرد فإن مالكا و أبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى ـ قال ـ ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس ـ قال ـ ويريان معا تخصيص القياس ونقص العلة ولا يرى الشافعي لعلة الشرع ـ إذا ثبت ـ تخصيصا
هذا ما قال ابن العربي ويشعر بذلك تفسير الكرخي أنه العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى
وقال بعض الحنفية : إنه القياس الذي يجب العمل به لأن العلة كانت علة بأثرها : سموا الضعيف الأثر قياسا والقوي الأثر استحسانا أي قياسا مستحسنا وكأنه نوع من العمل بأقوى القياسين وهو يظهر من استقراء مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية
بل قد جاء عن مالك أن الاستحسان تسعة أعشار العلم رواه أصبغ عن ابن القاسم عن مالك قال أصبغ في الاستحسان : قد يكون أغلب من القياس وجاء عن مالك : إن المفرق في القياس يكاد يفارقه السنة
وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبل وأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه فإن مثل هذا لا يكون تسعة أعشار العلم ولا أغلب من القياس الذي هو أحد الأدلة
وقال ابن العربي في موضع آخر : الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته وقسمه أقساما عد منها أربعة اقسام وهي ترك الدليل للعرف وتركه للمصلحة وتركه لليسير وتركه لرفع المشقة وإيثار التوسعة
وحده غير ابن العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك : استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي ـ قال ـ فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس
وعرفه ابن رشد فقال : الإستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس ـ هو أن يكون طرحا لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع
وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض
وإذا كان هذا معناه عن مالك و أبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة البتة لأن الأدلة يقيد بعضها ويخصص بعضها بعضا كما في الأدلة السنية مع القرآنية ولا يرد الشافعي مثل هذا أصلا فلا حجة في تسميته استحسانا لمبتدع على حال
ولا بد من الإتيان بأمثلة تبي المقصود بحول الله ويقتصر على عشرة أمثلة :
أحدها : أن يعدل بالمسألة عن نظائرنا بدليل الكتاب كقوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } فظاهر اللفظ العموم في جميع ما يتمول به وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية خاصة فلو قال قائل : مالي صدقة فظاهر لفظه يعم كل مال ولكنا نحمله على مال الزكاة لكونه ثبت الحمل عليه في الكتاب قال العلماء : وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب القرآن وهذا المثال أورده الكرخي تمثيلا لما قاله في الاستحسان
والثاني : أن يقول الحنفي : سؤر سباع الطير نجس قياسا على سباع البهائم وهذا ظاهر الأثر ولكنه ظاهر استحسانا لأن السبع ليس بنجس العين ولكن لضرورة تحريم لحمه فثبتت نجاسته بمجاورة رطوبات لعابه وإذا كان كذلك فارقه الطير لأنه يشرب بمنقاره وهو طاهر بنفسه فوجب الحكم بطهارة سؤره لأن هذا أثر قوي وإن خفي فترجع على الأول وإن كان أمره جليا والأخذ بأقوى القياسين متفق عليه
والثالث : أن أبا حنيفة قال : إذا شهد أربعة على رجل بالزنا ولكن عين كل واحد غير الجهة التي عينها ( الآخر ) فالقياس أن لا يحد ولكن استحسن حده ووجه ذلك أنه لا يحد إلا من شهد عليه أربعة فإذا عين كل واحد دارا فلم يأت على كل مرتبة بأربعة لامتناع اجتماعهم على رتبة واحدة فإذا عين كل واحد زاوية فالظاهر تعدد الفعل ويمكن التزاحف
فإذا قال : القياس أن لا يحد فمعناه أن الظاهر أنه لم يجتمع الأربعة على زنا واحد ولكنه يؤول في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدول فإنه إن لم يكن محدودا صار الشهود فسقه ولا سبيل إلى التفسيق ما وجدنا إلى العدول عنه سبيلا فيكون حمل الشهود على مقتضى العدالة عند الإمكان يجر ذلك الإمكان البعيد فليس هذا حكما بالقياس وإنما هو تمسك باحتمال تلقي الحكم من القرآن وهذا يرجع ـ في الحقيقة ـ إلى تحيقي مناطه
والرابع : أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف فإنه رد الأيمان إلى العرف مع أن اللغة تقتضي في ألفاظها غير ما يقتضيه العرف كقوله : والله لا دخلت مع فلان بيتأ : فهو يحنث بدخول كل موضع يسمى بيتا في اللغة والمسجد يسمى بيتا فيحنث على ذلك إلا أن عرف الناس أن لا يطلقوا هذا اللفظ عليه فخرج بالعرف عن مقتضى اللفظ فلا يحنث
والخامس : ترك الدليل لمصلحة كما في تضمين الأجير المشترك وإن لم يكن صانعا فإن مذهب مالك في هذه المسألة على قولين كتضمين صاحب الحمام الثياب وتضمين صاحب السفينة وتضمين السماسرة المشتركين وكذلك حمال الطعام ـ على رأي مالك ـ فإنه ضامن ولاحق عنده بالصناع والسبب في ذلك بعد السبب في تضمين الصناع
فإن قيل : فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان قلنا : نعم ! إلا أنهم صوروا الاستحسان بصورة الاستثناء من القواعد بخلاف المصالح المرسلة ومثل ذلك يتصور في مسألة التضمين فإن الإجراء مؤتمنون بالدليل لا بالبراءة الأصلية فصار تضمينهم في حيز المستثنى من ذلك الدليل فدخلت تحت معنى الاستحسان بذلك النظر
والسادس : أنهم يحكون الإجماع على إيجاب الغرم على من قطع ذنب بغلة القاضي يريدون غرم قيمة الدابة لا قيمة النقص الحاصل فيها ووجه ذلك ظاهر فإن بغلة القاضي لا يحتاج إليها إلا للركوب وقد امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب حتى صارت بالنسبة إلى ركوب مثله في حكم العدم فألزموا الفاعل غرم قيمة الجميع
وهو متجه بحسب الغرض الخاص وكان الأصل أن لا يغرم إلا قيمة ما نقصها القطع خاصة لكن استحسنوا ما تقدم
وهذا الإجماع مما ينظر فيه فإن المسألة ذات قولين في المذهب وغيره ولكن الأشهر في المذهب المالكي ما تقدم حسبما نص عليه القاضي عبد الوهاب
والسابع : ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق فقد أجازوا التفاصيل اليسير في المراطلة الكثيرة وأجازوا البيع بالصرف إذا كان أحدهما تابعا للآخر وأجازوا بدل الدرهم الناقص بالوازن لنزارة ما بينهما بينهما والأصل المنع في الجميع لما في الحديث من أن الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء ولأن من زاد أو ازداد فقد أربى ووجه ذلك أن التافه في حكم العدم ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج والمشقة وهما مرفوعان عن المكلف
والثامن : أن في العتبية من سماع أصبغ في الشريكين يطآن الأمة في طهر واحد فتأتي فتأتي بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر أنه يكشف منكر الولد عن وطئه الذي أقر به فإن كان في صفته ما يمكن معه الإنزال لم يلتفت إلى إنكاره وكان كما لو اشتركا فيه وإن كان يدعي العزل من الوطء الذي أقر به فقال أصبغ : إني أستحسن ها هنا أن ألحقه بالآخر والقياس أن يكونا سواء فلعله غلب ولا يدري
وقد قال عمرو بن العاص في نحو هذا : إن الوكاء قد ينقلب ـ قال ـ والاستحسان ها هنا أن ألحقه بالآخر والقياس أن يكونا في العلم قد يكون أغلب من القياس ( ؟ ) ـ ثم حكى عن مالك ما تقدم ووجه ذلك ابن رشد بأن الأصل : من وطئ أمته فعزل عنها وأتت بولد لحق به وإن كان له منكرا وجب على قياس ذلك إذا كانت بين رجلين فوطئاها جميعا في طهر واحد وعزل أحدهما عنها فأنكر الولد وادعاه الآخر الذي لم يعزل عنها أن يكون الحكم في ذلك بمنزلة ما إذا كانا جميعا يعزلان أو ينزلان والاستحسان ـ كما قال ـ أن يلحق الولد بالذي ادعاه وأقر أنه كان ينزل وتبرأ منه الذي أنكره وادعى أنه كان يعزل لأن الولد يكون مع الإنزال غالبا ولا يكون مع العزل إلا نادرا فيغلب على الظن أن الولد إنما هو للذي ادعاه وكان ينزل لا الذي أنكره وهو يعزل والحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام وله في هذا الحكم تأثير فوجب أن يصار إليه استحسانا ـ كما قال أصبغ ـ وهو ظاهر فيما نحن فيه
والتاسع : ما تقدم أولا من أن الأمة استسحنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل والأصل في هذا المنع إلا أنهم أجازوا لا كما قال المحتجون على البدع بل لأمر آخر هو من هذا القبيل الذي ليس بخارج عن الأدلة فأما تقدير العوض فالعرف هو الذي قدره فلا حاجة إلى التقدير وأما مدة اللبث وقدر الماء المستعمل فإن لم يكن ذلك مقدرا بالعرف أيضا فإنه يسقط للضرورة إليه
وذلك لقاعدة فقهية وهي أن نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه وهو يضيق أبواب المعاملات وهو تحسيم ابواب المفاوضات ( ؟ ) ونفي الضرر إنما يطلب تكميلا ورفعا لما عسى أن يقع من نزاع فهو من الأمور المكملة والتكميلات إذا أفضى اعتبارها إلى إبطال المكملات سقطت جملة تحصيلا للمهم ـ حسبما تبين في الأصول ـ فوجب أن يسامح في بعض أنواع الغرر التي لا ينفك عنها إذ يشق طلب الانفكاك عنها فسومح المكلف بيسير الغرر لضيق الاحتراز مع تفاهة ما يحصل من الغرر ولم يسامح في كثيرة إذ ليس في محل الضرورة ولعظيم ما يترتب عليه من الخطر لكن الفرق بين القليل والكثير غير منصوص عليه في جميع الأمور وإنما نهى عن بعض أنواعه مما يعظم فيه الغرر فجعلت أصولا يقاس عليها غير القليل أصلا في عدم الاعتبار وفي الجواز وصار الكثير في حكم المنع ودار في الأصلين فروع تتجاذب العلماء النظر فيها فإذا قل الغرر وسهل الأمر وقل النزاع ومست الحاجة إلى المسامحة فلا بد من القول بها ومن هذا القبيل مسألة التقدير في ماء الحمام ومدة اللبث
قال العلماء : ولقد بالغ مالك في هذا الباب وأمعن فيه فيجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وإن كان لا ينضبط مقدار أكله ليسار أمره وخفة خطبه وعدم المشاحة وفرق بين تطرق يسير الغرر إلى الأجل فأجازه وبين تطرقه للثمن فمنعه فقال : يجوز للانسان أن يشتري سلعة إلى الحصاد أو إلى الجذاذ وإن كان اليوم بعينه لا ينضبط ولو باع سلعة بدرهم أو ما يقاربه لم يجز والسبب في التفرقة المضايقة في تعيين الأثمان وتقديرها ليست في العرف ولا مضايقة في الأجل إذ قد يسامح البائع في التقاضي الأيام ولا يسامح في مقدار الثمن على حال
ويعضده ما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة و السلام أمر بشراء الإبل إلى خروج المصدق وذلك لا يضبط يومه ولا يعين ساعته ولكنه على التقريب والتسهيل
فتأملوا كيف وجه الاستثناء من الإصول الثابتة بالحرج والمشقة
وأين هذا من زعم الزاعم أنه استحسان العقل بحسب العوائد فقط ؟ فتبين لك بون ما بين المنزلتين
العاشر : أنهم قالوا : إن من جملة أنواع الإستحسان مراعاة خلاف العلماء وهو أصل في مذهب مالك ينبني عليه مسائل كثيرة
منها : أن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه أنه لا يتوضأ به بل يتيمم ويتركه فإن توضأ به وصلى أعاد ما دام في الوقت ولم يعد بعد الوقت وإنما قال : يعيد في الوقت مراعاة لقول من يقول : إنه طاهر مطهر ويروى جواز الوضوء به ابتداء وكان قياس هذا القول أن يعيد أبدا إذ لم يتوضأ إلا بماء يصح له تركه والانتقال عنه إلى التيمم
ومنها : قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه : إن لم يتفق على فساده فيفسخ بطلاق ويكون فيه الميراث ويلزم فيه الطلاق على حده في النكاح الصحيح فإن اتفق العلماء على فساده فسخ بغير طلاق ولا يكون فيه ميراث ولا يلزم فيه طلاق
ومنها : مسألة من نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع وكان مع الإمام وجب أن يتمادى لقول من قال : إن ذلك يجزئه فإذا سلم الإمام أعاد هذا المأموم
وهذا المعنى كثير جدا في المذهب ووجهه أنه راعى دليل المخالف في بعض الأحوال لأنه ترجح عنده ولم يترجح عنده في بعضها فلم يراعه
ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف إلى بلاد المغرب وإلى بلاد أفريقية لإشكال عرض فيها من وجهين : أحدهما مما يخص هذا الموضع على فرض صحتها وهو ما أصلها من الشريعة وعلام تبنى من قواعد أصول الفقه ؟ فإن الذي يظهر الآن أن الدليل هو المتبع فحيثما صار صير إليه ومتى رجح للمجتهد أحد الدليلين على الآخر ـ ولو بأدنى وجوه الترجيح ـ وجب التعويل عليه وإلغاء ما سواه على ما هو مقرر في الأصول فإذا رجوعه ـ أعني المجتهد ـ إلى قول الغير إعمال لدليله المرجوح عنده وإهمال للدليل الراجح عنده الواجب عليه اتباعه وذلك على خلاف القواعد
فأجابني بعضهم بأجوبة منها الأقرب والأبعد إلا أني راجعت بعضهم بالبحث وهو أخي ومفيدي أبو العباس بن القباب رحمه الله عليه فكتب إلي بما نصه :
وتضمن الكتاب المذكور عودة السؤال في مسألة مراعاة الخلاف وقلتم إن رجحان إحدى الأمارتين على الأخرى أن تقديمها على الأخرى اقتضى ذلك عدم المرجوحة مطلقا واستشنعتم أن يقول المفتي هذا لا يجوز ابتداء وبعد الوقوع يقول بجوازه لأنه يصير الممنوع إذا فعل جائزا وقلتم : إنه إنما يتصور الجمع في هذا النحو في منع التنزيه لا منع التحريم إلى غير ذلك مما أوردتم في المسألة
وكلها إيرادات شديدة صادرة عن قريحة قياسية منكرة لطريقة الاستحسان وإلى هذه الطريقة ميل فحول من الأئمة والنظار حتى قال الإمام أبو عبد الله الشافعي : من استحسن فقد شرع
ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان ـ كما في علمكم ـ حتى قالوا : أصح عبارة فيه أنه معنى ينقدح في نفس المجتهد تعسر العبارة عنه فإذا كان هذا أصله الذي ترجع فروعه إليه فكيف ما يبنى عليه ؟ فلا بد أن تكون العبارة عنها أضيق
ولقد كنت أقول بمثل ما قال هؤلاء الأعلام في طرح الاستحسان وما بنى عليه ولولا أنه أعتضد وتقوى لوجدانه كثيرا في فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة وجمهورهم مع عدم النكير فتقوى ذلك عندي غاية وسكنت إليه النفس وانشرح إليه الصدر ووثق به القلب فلأمر باتباعهم والاقتداء بهم رضي الله عنهم
فمن ذلك المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره إلا بعد البناء فأبانها عليه بذلك عمر ومعاوية والحسن رضي الله عنهم وكل ما أوردتم في قضية السؤال وأرد عليه فإنه إذا تحقق أن الذي لم يبن هو الأول فدخول الثاني بها دخول بزوج غيره وكيف يكون غلطة على زوج غيره مبيحا على الدوام ومصححا لعقده الذي لم يصادف محلا ومبطلا لعقد نكاح مجمع على صحته لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا ؟ وإنما المناسب أن الغلط يرفع عن الغالط الإثم والعقوبة لا إباحة زوج غيره دائما ومنع زوجها منها
ومثل ذلك ما قاله العلماء في مسألة امرأة المفقود : أنه إن قدم المفقود قبل نكاحها فهو أحق بها وإن كان بعد نكاحها والدخول بها بانت وإن كانت بعد العقد وقبل البناء فقولان فإنه يقال : الحكم لها بالعدة من الأول إن كان قطعا لعصمته فلا حق له فيها ولو قدم قبل تزوجها أو ليس بقاطع للعصمة فكيف تباح لغيره في عصمة المفقود ؟
وما روي عن عمر وعثمان في ذلك أغرب وهو أنهما قالا : إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أو صداقها فإن اختار صداقها بقيت للثاني فأين هذا من القياس ؟ وقد صحح ابن عبد البر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان رضي الله عنهما ونقل عن علي رضي اله عنه أنه قال بمثل ذلك أو أمضى الحكم به وإن كان الأشهر عنه خلافه ومثله في قضايا الصحابة كثير من ذلك
قال ابن المعدل لو أن رجلين حضرهما وقت الصلاة فقام أحدهما فأوقع الصلاة بثوب نجس مجانا ( ؟ ) وقعد الآخر حتى خرج الوقت ولا يقاربه ( ؟ ) مع نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع على وجوب النجاسة ( ؟ ) عامدا جمع الناس أنه لا يساوي مؤخرها على وجوب النجاسة حال الصلاة وممن نقله اللخمي و المازري وصححه الباجي وعليه مضى عبد الوهاب في تلقينه
وعلى الطريقة التي أوردتم أن المنهي عنه ابتداء غير معتبر ـ أحرى بكون أمر هذين الرجلين بعكس ما قال ابن المعدل لأن الذي صلى بعد الوقت قضى ما فرط فيه والآخر لم يعمل كما أمر ولا قضى شيئا وليس كل منهي عنه ابتداء غير معتبر بعد وقوعه
وقد صحح الدارقطني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ] وأخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها : [ أيما امرأة نكحت بغيرإذن مواليها فنكاحها باطل ـ ثلاث مرات ـ فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها ] فحكم أولا ببطلان العقد وأكده بالتكرار ثلاثا وسماه زنا وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة لكنه صلى الله عليه و سلم عقبة بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله : [ ولها مهرها بما أصاب منها ومهر البغي حرام ]
وقد قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله } فعلل النهي عن استحلاله بابتغائهم فضل الله ورضوانه مع كفرهم بالله تعالى الذي لا يصح معه عبادة ولا يقبل عمل وإن كان هذا الحكم الآن منسوخا فذلك لا يمنع الاستدلال به في هذا المعنى
ومن ذلك قول الصديق رضي الله عنه : وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ولهذا لا يسبى الراهب وترك له ماله أو ما قل منه على الخلاف في ذلك وغيره ممن لا يقاتل يسبى ويملك وإنما ذلك لما زعم أنه حبس نفسه له وهي عبادة الله تعالى وإن كانت عبادته أبطل الباطل فكيف يستبعد اعتبار عبادة مسلم على وفق دليل شرعي لا يقطع بخطأ فيه وإن كان يظن ذلك ظنا وتتبع مثل هذا يطول
وقد اختلف فيما تحقق فيه نهي من الشارع : هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟ وفيه بين الفقهاء والأصوليين ما لا يخفى عليكم فكيف بهذا ؟
وإذا خرجت المسألة المخلف فيها إلى أصل مختلف فيه فقد خرجت عن حيز الإشكال ولم يبق إلا الترجيح لبعض تلك المسائل ويرجح كل أحد ما ظهر له بحسب ما وفق له ولنكتف بهذا القدر في هذه المسألة
انتهى ما كتب لي به وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الاستحسان فلا يمكن مع هذا التقرير كله أن يتمسك به من أراد أن يستحسن بغير دليل أصلا
فصل : فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به
فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به أولا : فأما من حد الاستحسان بأنه : ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه فكان هؤلاء يرون هذا النوع من جملة أدلة الأحكام ولا شك أن العقل يجوز أن يرد الشرع بذلك بل يجوز أن يرد بأن ما سبق إلى أوهام العوام ـ مثلا ـ فهو حكم الله عليهم فيلزمهم العمل بمقتضاه ولكن لم يقع مثل هذا ولم يعرف التعبد به لا بضرورة ولا بنظر ولا بدليل من الشرع قاطع ولا مظنون فلا يجوز إسناده لحكم الله لأنه ابتداء تشريع من جهة العقلوأيضا فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباط والرد إلى ما فهموا من الأصول الثابتة ولم يقل أحد منهم : إني حكمت في هذا بكذا لأن طبعي مال إليه أو لأنه يوافق محبتي ورضائي ولو قال ذلك لاشتد عليه التكبير وقيل له : من أين لك أن تحكم على عبادة الله بمحض ميل النفس وهوى القلب ؟ هذا مقطوع ببطلانه
بل كانوا يتناظرون ويعترض بعضهم بعضا على مأخذ بعض ويحصرون ضوابط الشرع
وأيضا فلو رجع الحكم إلى مجرد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة لأن الناس تختلف أهواؤهم وأغراضهم في الأطعمة والأشربة واللباس وغير ذلك ولا يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضا : لم كان هذا الماء أشهى عندك من الآخر ؟ والشريعة ليست كذلك
على أن أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحدا ولا يفاتحون عالما ولا غيره فيما يبتغون خوفا من الفضيحة أن لا يجدوا مستندا شرعيا وإنما شأنهم إذا وجدوا عالما أو لقوة أن يصانعوا وإذا وجدوا جاهلا عاميا ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم ويلبسوا دينهم فإذا عرفوا منهم الحيرة والالتباس ألقوا إليهم من بدعهم على التدريج شيئا فشيئا وذموا أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليها وأن هذه الطائفة هم أهل الله وخاصيته وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون إليهم حتى يهووا بهم في نار جهنم وأما أن يأتوا الأمر من بابه ويناظروا عليه العلماء الراسخين فلا
وتأمل ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية غيرهم إلى مذهبهم تجدهم لا يعتمدون إلا على خديعة الناس من غير تقرير علم والتحيل عليهم بأنواع الحيل حتى يخرجونهم من السنة أو عن الدين جملة ولولا الإطالة لأتيت بكلامه فطالعه في كتابه فضائح الباطنية
وأما الحد الثاني فقد رد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما شاء واكتفى بمجرد القول فألجأ الخصم إلى الإبطال وهذا يجر فسادا لا خفاء له وإن سلم فذلك الدليل إن كان فاسدا فلا عبرة به وإن كان صحيحا فهو راجع إلى الأدلة الشرعية فلا ضرر فيه
وأما الدليل الأول فلا متعلق به فإن أحسن الاتباع إلينا اتباع الأدلة الشرعية وخصوصا القرآن فإن الله تعالى يقول ك { الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها } وجاء في صحيح الحديث ـ خرجه مسلم ـ [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في خطبته : أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله ] فيفتقر أصحاب الدليل أن يبينوا أن ميل الطباع أو أهواء النفوس مما أنزل إلينا فضلا عن أن يقول من أحسنه
وقوله تعالى : { الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه } الآية يحتاج إلى بيان أن ميل النفوس يسمى قولا وحينئذ ينظر إلى كونه أحسن القول كما تقدم وهذا كله فاسد
ثم إنا نعارض هذا الاستحسان بأن عقولنا تميل إلى إبطاله وأنه ليس بحجة وإنما الحجة الأدلة الشرعية المتلقاة من الشرع
وأيضا فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظر إذا فرض أن الحكم يتبع مجرد ميل النفوس وهوى الطباع وذلك محال للعمل بأن ذلك مضاد للشريعة فضلا عن أن يكون من أدلتها
وأما الدليل الثاني فلا حجة فيه من أوجه :
أحدها : أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن والأمة لا تجتمع على باطل فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعا لأن الإجتماع يتضمن دليلا شرعيا فالحديث دليل عليكم لا لكم
والثاني : أنه خبر واحد في مسألة قطعية فلا يسمع
والثالث : أنه إذا لم يرد به أهل الإجماع وأريد بعضهم فيلزم عليه استحسان العوام وهو باطل بإجماع لا يقال : إن المراد استحسان أهل الاجتهاد لأنا نقول : هذا ترك للظاهر فيبطل الاستدلال ثم إنه لا فائدة في اشتراط الاجتهاد لأن المستحسن بالفرض لا ينحصر في الأدلة فأي حاجة إلى اشتراط الاجتهاد ؟
فإن قيل : إنما يشترط حذرا من مخالفة الأدلة فإن العامي لا يعرفها قيل : بل المراد استحسان ينشأ عن الأدلة بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم قصروا أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشرع
فالحاصل إن تعلق المبتدعة بمثل هذه الأمور تعلق بما لا يغنيهم ولا ينفعهم البتة لكن ربما يتعلقون في آحاد بدعتهم بآحاد شبه ستذكر في مواضعها إن شاء الله ومنها ما قد مضى
فصل : فإن قيل : أفليس في الأحاديث
فإن قيل : أفليس في الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما يقع في القلب ويجري في النفس وإن لم يكن ثم دليل صريح على حكم من أحكام الشرع ولا غير صريح ؟ فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول : [ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة ]وخرج مسلم [ عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البر والإثم فقال : البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه ] وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : [ قال رجل يا رسول الله ما الإيمان ؟ قال : إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن قال : يا رسول الله ! فما الإثم ؟ قال : إذا حاك شيء في صدرك فدعه ] وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : [ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ] و [ عن وابصة رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البر والإثم فقال : يا وابصة ! استفت قلبك واستفت نفسك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ] وخرج البغوي في معجمه عن عبد الرحمن بن معاوية :
[ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ! ما يحل لي مما يحرم علي ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم فرد عليه ثلاث مرات كل ذلك يسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : أين السائل ؟ فقال : أنا ذا يا رسول الله فقال : ـ ونقر بأصبعه ـ : ما أنكر قلبك فدعه ]
وعن عبد الله قال : الإثم حواز القلوب فما حاك من شيء في قلبك فدعه وكل شيء فيه نظرة فإن للشيطان فيه مطمعا وقال أيضا : الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وعن أبي الدرداء رضي الله عنه : أن الخير طمأنينة وأن الشر ريبة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال شريح : دع ما يريبك إلى ما يريبك فوالله ما وجدت فقد شيء تركته ابتغاء وجه الله
فهذه ظهر من معناها الرجوع في جملة من الأحكام الشرعية إلى ما يقع بالقلب ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطر وأنه إذا اطمأنت النفس إليه فالإقدم عليه صحيح وإذا توقفت أو ارتابت فالإقدام عليه محظور وهو عين ما وقع إنكاره من الرجوع إلى الاستحسان الذي يقع بالقلب ويميل إليه الخاطر وإن لم يكن ثم دليل شرعي فإنه لو كان هنالك دليل شرعي أو كان هذا التقرير مقيدا بالأدلة الشرعية لم يحل به على ما في النفوس ولا على ما يقع بالقلوب مع أنه عندكم عبث وغير مفيد كمن يحيل بالأحكام الشرعية على الأمور الوفاقية أو الأفعال التي لا ارتباط بينها وبين شرعية الأحكام فدل ذلك على أن لاستحسان العقول وميل النفوس أثرا في شرعية الأحكام وهو المطلوب
والجواب : أن هذه الأحاديث وما كان في معناها قد زعم الطبري في تهذيب الآثار أن جماعة من السلف قالوا بتصحيحها والعمل بما دل عليه ظاهرها وأتى بالآثار المتقدمة عن عمر وابن مسعود وغيرهما ثم ذكر عن آخرين القول بتوهينها وتضعيفها وإحالة معانيها
وكلامه وترتيبه بالنسبة إلى ما نحن فيه لائق أن يؤتى به على وجهه فأتيت به على تحري معناه دون لفظه لطوله فحكى عن جماعة أنهم قالوا : لا شيء من أمر الدين إلا وقد بينه الله تعالى بنص عليه بمعناه فإن كان حلالا فعلى العامل به إذا كان عالما تحليله أو حراما فعليه تحريمه أو مكروها غير حرام فعليه اعتقاد التحليل أو الترك تنزيها
فأما العامل بحديث النفس والعارض في القلب فلا فإن الله حظر ذلك على نبيه فقال : { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله } فأمره بالحكم بما أراه الله لا بما رآه وحدثته به نفسه فغيره من الشرك أولى أن يكون ذلك محظورا عليه وأما إن كان جاهلا فعليه مسألة العلماء دون ما حدثته نفسه
ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال : إيها الناس ! قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة ان تضلوا بالناس يمينا وشمالا
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ما كان في القرآن من خلال أو حرام فهو كذلك وما سكت عنه فهو مما عفي عنه
وقال مالك : قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد تم هذا الأمر واستكمل فينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه ولا ينبع الرأي فإنه من اتبع الرأي جاءه رجل آخر أقوى في الرأي منه فاتبعه فكلما غلبه رجل اتبعه أرى أن هذا بعد لم يتم
واعملوا من الآثار بما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إذا اعتصمتم به : كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض ]
وروي عن عمرو بن [ شعيب عن أبيه عن جده ] ـ [ خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما وهم يجادلون في القرآن فخرج و وجهه أحمر كالدم فقال : يا قوم ! على هذا هلك من كان قبلكم جادلوا في القرآن وضربوا بعضه ببعض فما كان من حلال فاعملوا به وما كان من حرام فانتهوا عنه وما كان من متشابه فآمنوا به ]
و [ عن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه قال : ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فيه فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا : { وما كان ربك نسيا } ]
قالوا : فهذه الأخبار وردت بالعمل بما في كتاب الله والإعلام بأن العامل به لن يضل ولم يأذن لأحد في العمل بمعنى ثالث غير ما في الكتاب والسنة ولو كان ثم ثالث لم يدع بيانه فعدل على أن لا ثالث ومن ادعاه فهو مبطل
قالوا : فإن قيل : فإنه عليه السلام قد سن لأمته وجها ثالثا وهو قوله : [ استفت قلبك ] وقوله : [ الإثم حواز القلوب ] إلى غير ذلك قلنا : لو صحت هذه الأخبار لكان ذلك إبطالا لأمره بالعمل بالكتاب والسنة إذ صحا معا لأن أحكام الله ورسوله لم ترد بما استحسنته النفوس واستقبحته وإنما كان يكون وجها ثالثا لو خرج شيء من الدين عنهما وليس بخارج فلا ثالث يجب العمل به
فإن قيل : قد يكون قوله : [ استفت قلبك ] ونحوه أمرا لمن في مسألته نص من كتاب ولا سنة واختلفت فيه الأمة فيعد وجها ثالثا قلنا : لا يجوز ذلك لأمور :
أحدها : أن كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة فلو كان فتوى القلب ونحوه دليلا لم يكن لنصت الدلالة الشرعية عليه معنى فيكون عبثا وهو باطل
والثاني : أن الله تعالى قال : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث النفوس وفتيا القلوب
والثالث : أن الله تعالى قال : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه من أمر محمد صلى الله عليه و سلم ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهم
والرابع : أن الله تعالى قال لنبيه احتجاجا على من أنكر وحدانيته : { أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت } إلى آخرها فأمرهم بالإعتبار بعبرته والإستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به ولم يأمرهم أن يستفتوا فيه نفوسهم ويصدوا عما اطمأنت إليه قلوبهم وقد وضع الأعلام والأدلة فالواجب في كل ما وضع الله عليه الدلالة أن يستدل بأدلته على ما دلت دون فتوى النفوس وسكون القلوب من أهل الجهل بأحكام الله
وهذا ما حكاه الطبري عمن تقدم ثم اختار إعمال تلك الأحاديث إما لأنها صحت عنده أو صح منها عنده ما تدل عليه معانيها كحديث :
[ الحلال بين والحرام بين ] إلى آخر الحديث فإنه صحيح خرجه الإمامان ولكنه لم يعملها في كل من أبواب الفقه إذ لا يمكن ذلك في تشريع الأعمال وإحداث التعبدات فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال : إذا اطمأنت نفسك إلى هذا العمل فهو بر أو : استفت قلبك في إحداث هذا العمل فإن اطمأنت إليه نفسك فاعمل به وإلا فلا
وكذلك في النسبة إلى التشريع التركي لا يتأتى تنزيل معاني الأحاديث عليه بأن يقال : إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني فاتركه وإلا فدعه أي فدع الترك واعمل به وإنما يستقيم إعمال الأحاديث المذكورة فيما أعمل فيه قوله عليه الصلاة و السلام : [ الحلال بين والحرام بين ] الحديث
وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح واللباس وغير ذلك مما في هذا المعنى فمنه ما هو بين الحلية وما هو بين التحريم وما فيه إشكال وهو الأمر المشتبه الذي لا يدرى أحلال هو أم حرام ؟ فإن ترك الإقدام أولى من الإقدام مع جهلة بحاله نظير قوله عليه السلام : [ إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ] فهذه التمرة لا شك أنها لم تخرج من إحدى الحالين : إما من الصدقة وهي حرام عليه وإما من غيرها وهي حلال له فترك أكلها حذرا من أن تكون من الصدقة في نفس الأمر
قال الطبري : فكذلك حق الله على العبد فيما اشتبه عليه مما هو سعة من تركه والعمل به أو مما هو غير واجب ـ أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه إذ يزول بذلك عن نفسه الشك كمن يريد خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياها ولا يعلم صدقها من كذبها فإن تركها أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة وليس تزوجه إياها بواجب بخلاف ما لو أقدم فإن النفس لا تطمئن إلى حلية تلك الزوجة
وكذلك قول عمر إنما هو فيما أشكل أمره في البيوع فلم يدر حلال هو أم حرام ؟ ففي تركه سكون النفس وطمأنينة القلب كما في الإقدام شك : هل هو آثم أم لا ؟ وهو معنى قوله عليه السلام للنواس ووابصة رضي الله عنهما ودل على ذلك حديث المشتبهات لا ما ظن أولئك من أنه أمر للجهال أن يعلموا بما رأته أنفسهم ويتركوا ما استقبحوه دون أن يسألوا علماءهم
قال الطبري فإن قيل : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام فسأل العلماء فاختلفوا عليه فقال بعضهم : قد بانت منك بالثلاث : وقال بعضهم : إنها حلال غير أن عليك كفارة يمين وقال بعضهم : ذلك إلى نيته إن أراد الطلاق فهو طلاق أو الظهار فهو ظهار أو يمينا فهو يمين وإن لم ينو شيئا فليس بشيء : أيكون هذا اختلافا في الحكم كإخبار المرأة بالرضاع فيؤمر هنا بالفراق كما يؤمر هناك أن لا يتزوجها خوفا من الوقوع في المحظور أو لا ؟ قيل : حكمه في مسألة العلماء أن يبحث عن أحوالهم وأمانتهم ونصيحتهم ثم يقلد الأرجح فهذا ممكن والحزازة مرتفعة بهذا البحث بخلاف ما إذا بحث مثلا عن أحوال المرأة فإن الحزازة لا تزول وإن أظهر البحث أن أحوالها غير حميدة فهما على هذا مختلفان وقد يتفقان في الحكم إذا بحث عن العلماء فاستوت أحوالهم عنده لم يثبت له ترجيح لأحدهم فيكون العمل المأمور به من الاجتناب كالمعمول به في مسألة المخبرة بالرضاع سواء إذ لا فرق بينهما على هذا التقدير انتهى معنى كلام الطبري
وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء على المستفتي أنه غير مخير بل حكمه حكم من التبس عليه الأمر فلم يدر أحلال هو أم حرام ؟ فلا خلاص له من الشبهة إلا باتباع أفضلهم والعمل بما أفتى به وإلا فالترك إذ لا تطمئن النفس إلا بذلك حسبما اقتضته الأدلة المتقدمة
فصل ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال
ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال على كل من اختار استفتاء القلب مطلقا أو بقيد وهو الذي رآه الطبري وذك أن حاصل الأمر يقتضي أن فتاوى القلوب وما اطمأنت إليه النفوس معتبر في الأحكام الشرعية وهو التشريع بعينه فإن طمأنينة النفس القلب مجردا عن الدليل إما أن تكون معتبرة أو غير معتبرة شرعا فإن لم تكن معتبرة فهو خلاف ما دلت عليه تلك الأخبار وقد تقدم أنها معتبرة بتلك الأدلة وإن كانت معتبرة فقد صار ثم قسم ثالث غير الكتاب والسنة وهو غير ما نفاه الطبري وغيرهوإن قيل : إنها تعتبر في الإحجام دون الإقدام لم تخرج تلك عن الإشكال الأول لأن كل واحد من الإقدام والإحجام فعل لا بد أن يتعلق به حكم شرعي وهو الجواز وعدمه وقد علق ذلك بطمأنينة النفس أو عدم طمأنينتها فإن كان ذلك عن دليل فهو ذلك الأول بعينه باق على كل تقدير
والجواب : أن الكلام الأول صحيح وإنما النظر في تحقيقه
فاعلم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين : تظر في دليل الحكم ونظر في مناطه فأما النظر في دليل الحكم لا يمكن أن يكون إلا من الكتاب والسنة أو ما يرجع إليهما عن إجماع أو قياس أو غيرهما ولا يعتبر فيه طمأنينة النفس ولا نفي ريب القلب إلا من جهة اعتقاد كون الدليل دليلا أو غير دليل ولا يقول أحد ( ؟ ) إلا أهل البدع الذين يستحسنون الأمر بأشياء لا دليل عليها أو يستقبحون كذلك من غير دليل إلا طمأنينة النفس ( ؟ ) أن الأمر كما زعموا وهو مخالف لإجماع المسلمين أ
وأما النظر في مناط الحكم فإن المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتا بدليل شرعي فقط بل يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل فلا يشترط فيه بلوغ درجة الاجتهاد بل لا يشترط فيه العلم فضلا : عن درجة الاجتهاد : ألا ترى أن العامي إذا سئل عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إذا فعله المصلي : هل تبطل به الصلاة أم لا ؟ فقال العامي : إن كان يسيرا فمغتفر وإن كان كثيرا فمبطل لم يغتفر في ا لسير إلى أن يحققه له العالم بل العاقل يفرق بين الفعل اليسير والكثير فقد انبنى ها هنا الحكم ـ وهو البطلان أو عدمه ـ على ما يقع بنفس
العامي وليس واحدا من الكتاب أو السنة لأنه ليس ما وقع بقلبه دليلا على الحكم وإنما هو مناط الحكم فإذا تحقق له المناط بأي وجه تحقق فهو الملطوب فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي
وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطهارة وفرقنا بين اليسير والكثير في التفريق الحاصل أثناء الطهارة فقد يكتفي العامي بذلك حسبما يشهد قلبه في اليسير أو الكثير فتبطل طهارته أو تصح بناء على ذلك الواقع في القلب لأنه نظر في مناط الحكم
فإذا ثبت هذا فمن ملك لحم شاة ذكية حل له أكله لأن حليته ظاهرة عنده إذا حصل له شرط الحلية لتحقيق مناطها بالنسبة إليه : أو ملك لحم شاة ميتة لم يحل له أكله لأن تحريمه ظاهر من جهة فقده شرط الحلية فتحقق مناطها بالنسبة إليه وكل واحد من المناطين راجع إلى ما وقع بقلبه واطمأنت إليه نفسه لا بحسب الأمر في نفسه الا ترى أن اللحم قد يكون واحدا بعينه فيعتقد واحد حليته بناء على ما تحقق له من مناطه بحسبه ويعتقد آخر تحريمه بناء على ما تحقق له من مناطه بحسبه فيأكل أحدهما حلالا ويجب على الآخر الاجتناب لأنه حرام ؟ ولو كان ما يقع بالقلب يشترط فيه أن يدل عليه دليل شرعي لم يصح هذا المثال وكان محالا لأن أدلة الشرع لا تناقض أبدا فإذا فرضنا لحما أشكل على المالك تحقيق مناطه لم ينصرف إلى إحدى الجهتين كاختلاط الميتة بالذكية واختلاط الزوجة بالأجنبية
فها هنا قد وقع الريب والشك والإشكال والشبهة
وهذا المناط محتاج إلى دليل شرعي يبين حكمه وهي تلك الأحاديث المتقدمة كقوله : [ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ] وقوله : [ البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في صدرك ] كأنه يقول : إذا اعتبرنا باصطلاحنا ما تحققت مناطه في الحلية أو الحرمة فالحكم فيه من الشرع بين
وما أشكل عليك تحقيقه فاتركه وإياك والتلبس به وهو معنى قوله ـ إن صح ـ : [ استفت قلبك ] وإن أفتوك فإن تحقيك لمناط مسألتك أخص بك من تحقيق غيرك له إذا كان مثلك
ويظهر ذلك فيما إذا أشكل عليك المناط ولم يشكل على غيرك لأنه لم يعرض له ما عرض لك
وليس المراد بقوله : [ وإن أفتوك ] أي إن نقلوا إليك الحكم الشرعي فاتركه وانظر ما يفتيك به قلبك فإن هذا باطل وتقول على التشريع الحق وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط
نعم قد لا يكون ذلك درية أو أنسا بتحقيقه لك غيرك وتقلده فيه وهذه الصورة خارجة عن الحديث كما أنه قد يكون تحقيق المناط أيضا موقوفا على تعريف الشارع كحد الغنى الموجب للزكاة فإنه يختلف باختلاف الأحوال فحققه الشارع بعشرين دينارا ومائتي درهم وأشباه ذلك وإنما النظر هنا فيما وكل تحقيقه إلى المكلف
فقد ظهر معنى المسألة وأن الأحاديث لم تتعرض لاقتناص الأحكام الشرعية من طمأنينة النفس أو ميل القلب كما أورده السائل المستشكل وهو تحقيق بالغ والحمد لله الذي بنعته تتم الصالحات
الباب التاسع في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين
فاعلموا رحمكم الله أن الآيات الدالة على ذم البدعة وكثيرا من الأحاديث أشعرت بوصف لأهل البدعة وهو الفرقة الحاصلة حتى يكونوا بسببها شيعا متفرقة لا ينتظم شملهم بالإسلام وإن كانوا من أهله وحكم لهم بحكمه
ألا ترى أن قوله تعالى : { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء } وقوله تعالى : { ولا تكونوا من المشركين * من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا } الآية وقوله : { وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله } إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وصف التفرق ؟
وفي الحديث :
[ ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ] والتفرق ناشىء عن الاختلاف في المذاهب والآراء إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان ـ وهو الحقيقة ـ وإن جعلنا معنى التفرق في المذاهب فهو الاختلاف كقوله : { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا }
للإختلاف سببان : كسبي وغير كسبي
فلا بد من النظر في هذا الاختلاف ما سببه ؟ وله سببان ( أحدهما ) : لا كسب للعبادة فيه وهو الراجع إلى سابق القدر والآخر هو الكسبي وهو المقصود بالكلام عليه في هذا الباب إلا أن نجعل السبب الأول مقدمة فإن فيها معنى أصيلا يجب التثبت له على من أراد التفقه في البدع فنقول والله الموفق للصواب : آية ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وتفسيرها
قال الله تعالى : { ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم } فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون مختلفين أبدا مع أنه إنما خلقهم للاختلاف وهو قول جماعة من المفسرين في الآية وأن قوله : { ولذلك خلقهم } معناه : وللاختلاف خلقهم وهو مروي عن مالك بن أنس قال : خلقهم ليكونوا فريقا في الجنة وفريقا في السعير ونحوه عن الحسن فالضمير في خلقهم عائد على الناس فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما سبق في العلم وليس المراد ها هنا الاختلاف في الصور كالحسن والقبيح والطويل والقصير ولا في الألوان كالأحمر والأسود ولا في أصل الخلقة كالتام الخلق والأعمى والبصير والأصم والسميع ولا في الخلق كالشجاع والجبان والجواد والبخيل ولا فيما أشبه ذلك من الأوصاف التي هم مختلفون فيها
وإنما المراد اختلاف آخر وهو الاختلاف الذي بعث الله النبيين ليحكموا فيه بين المختلفين كما قال تعالى : { كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه } الآية وذلك الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان به أو يشقى في الآخرة والدنيا
هذا هو المراد من الآيات التي كرر فيها الاختلاف الحاصل بين الخلق أن هذا الاختلاف الواقع بينهم على أوجه :
فصل أحدها : الاختلاف في أصل النحلة
وهو قول جماعة من المفسرين منهم عطاء قال : { ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم } قال قال : اليهود والنصارى والمجوس والحنيفية ـ وهم الذين رحم ربك ـ الحنيفية خرجه ابن وهب وهو الذي يظهر لبادي الرأي في الآية المذكورةوأصل هذا الاختلاف هو في التوحيد والتوجه للواحد الحق سبحانه فإن الناس في عامة الأمر لم يختلفوا في أن لهم مدبرا يدبرهم وخالقا أوجدهم إلا أنهم اختلفوا في تعيينه على آراء مختلفة من قائل بالاثنين وبالخمسة وبالطبيعة أو الدهر أو بالكواكب إلى أن قالوا بالآدميين وبالشجر وبالحجارة وما ينحتون بأيديهم
ومنهم من أقر بواجب الوجود الحق لكن على آراء مختلفة أيضا إلى أن بعث الله الأنبياء مبينين لأممهم حق ما اختلفوا فيه من باطله فعرفوا بالحق على ما ينبغي ونزهوا رب الأرباب عما لا يليق بجلاله من نسبة الشركاء والأنداد وإضافة الصاحبة والأولاد فأقر بذلك من أقر به وهم الداخلون تحت مقتضى قوله : { إلا من رحم ربك } وأنكر من أنكر فصار إلى مقتضى قوله : { لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين } وإنما دخل الأولون تحت وصف الرحمة لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف إلى وصف الوفاق والألفة وهو قوله : { واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا } وهو منقول عن جماعة من المفسرين
وخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في قوله : { ولذلك خلقهم } خلق أهل الرحمة أن لا يختلفوا وهو معنى ما نقل عن مالك و طاوس في جامعه وبقي الآخرون على وصف الاختلاف إذ خالفوا الحق الصريح ونبذوا الدين الصحيح
وعن مالك أيضا قال : الذين رحمهم لم يختلفوا وقول الله تعالى : { كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين } إلى قوله : { فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه } ومعنى : { كان الناس أمة واحدة } فاختلفوا { فبعث الله النبيين } فأخبر في الآية أنهم اختلفوا ولم يتفقوا فبعث النبيين ليحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه من الحق وأن الذين آمنوا هداهم للحق من ذلك الاختلاف
وفي الحديث الصحيح :
[ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد ]
وخرج ابن وهب عن زيد بن أسلم في قوله تعالى : { كان الناس أمة واحدة } فهذا يوم أخذ ميثاقهم لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم { فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين } إلى قوله : { فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه }
وختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت واتخذ النصارى يوم الأحد فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه و سلم ليوم الجمعة
واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واستقبلت اليهود بيت المقدس وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه و سلم للقبلة
واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلي ولا يتكلم ومنهم من يصلي وهو يمشي وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه و سلم للحق من ذلك
واختلفوا في إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى نصرانيا وجعله الله حنيفا مسلما فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه و سلم للحق من ذلك
واختلفوا في عيسى عليه السلام فكفرت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما وجعلته النصارى إلها وولدا وجعله اللخ روحه وكلمته فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه و سلم للحق من ذلك
ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا القصد الأول فإن الله حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف لكن في الفروع دون الأصول وفب الجزئيات دون الكليات فلذلك لا يضر هذا الاختلاف
وقد نقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية أنه قال : أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم يعني لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها بقطع العذر بل لهم فيه أعظم العذر ومع أن الشارع لما علم أن هذا النوع من الاختلاف واقع أتى فيه بأصل يرجع إليه وهو قول الله تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } الآية فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يرد إلى الله وذلك رده إلى كتابه وإلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وذلك رده إليه إذا كان حيا وإلى سنته بعد موته وكذلك فعل العلماء رضي الله عنهم
إلا أن لقائل أن يقول : هل هم داخلون تحت قوله تعالى : { ولا يزالون مختلفين } أم لا ؟ والجواب : أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من أوجه
أحدها : أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة لقوله : { ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك } فإنها اقتضت قسمين : أهل الاختلاف والمرحومين فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف وإلا كان قسم الشيء قسيما له ولم يستقم معنى الاستثناء
والثاني : أنه قال فيها : { ولا يزالون مختلفين } فظاهر هذا أن وصف الاختلاف لازم لهم حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالفة بل إن خالف أحدهم في مسألة فإنما يخالف فيها تحريا لقصد الشارع فيها حتى إذا تبين له الخطأ فيها راجع نفسه وتلافى أمره فخلافه في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول فلم يكن وصف الاختلاف لازما ولا ثابتا فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والاتقطاع أليق في الموضع
والثالث : أنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجه فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدودا من أهل الاختلاف ـ ولو بوجه ما ـ لم يصح إطلاق القول في حقه : انه من أهل الرحمة وذلك باطل بإجماع أهل السنة
والرابع : أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربا من ضروب الرحمة وإذا كان من جملة الرحمة فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجا من قسم أهل الرحمة
وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة ما روي عن القاسم بن محمد قال : لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في العمل لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة وعن ضمرة بن رجاء قال : اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعلا يتذاكرن الحديث ـ قال ـ فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم ـ قال ـ وجعل القاسم يشق ذلك عليه حتى يتبين ذلك فيه فقال له عمر : لا تفعل ! فما يسرني باختلافهم حمر النعم وروى ابن وهب عن القاسم أيضا قال : لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يختلفون لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سنة
ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق لأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة ـ كما تقدم ـ فيضير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مكلفين باتباع خلافهم وهو نوع من تكليف ما لا يطاق وذلك من أعظم الضيق فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم فكان فتح باب الأمة للدخول في هذه الرحمة فكيف لا يدخلون في قسم من رحم ربك ؟ ! فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيها والحمد لله
وبين هذين الطريقين واسطة أدنى من الرتبة الأولى وأعلى من الرتبة الثانية وهي أن يقع الاتفاق في أصل الدين ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية وهو المؤدي إلى التفرق شيعا
فيمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف ولذلك صح عنه صلى الله عليه و سلم : [ أن أمته تفترق على بضع و سبعين فرقة ] وأخبر :
[ أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع ] وشمل ذلك الاختلاف الواقع في الأمم قبلنا ويرشحه وصف أهل البدع بالضلالة وإيعادهم بالنار وذلك بعيد من تمام الرحمة
ولقد كان عليه الصلاة و السلام حريصا على ألفتنا وهدايتنا حتى ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : [ لما حضر النبي صلى الله عليه و سلم ـ قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ـ فقال : هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فقال عمر : إن النبي صلى الله عليه و سلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول : قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه و سلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول كما قال عمر فلما كثر اللغط والإختلاف عند النبي صلى الله عليه و سلم قال : قوموا عني فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم ]
فكان ذلك ـ والله أعلم ـ وحيا أوحى الله إليه أنه إن كتب لهم ذلك الكتاب لم يضلوا بعده البتة فتخرج الأمة عن مقتضى قوله : { ولا يزالون مختلفين } بدخولها تحت قوله : { إلا من رحم ربك } فأبى الله إلا ما سبق به علمه من اختلافهم كما اختلف غيرهم رضينا بقضاء الله وقدره ونسأله أن يثبتنا على الكتاب والسنة ويميتنا على ذلك بفضله
وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع وأن من رحم ربك أهل السنة ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلقا بل مع إنزال القرآن محتمل العبارة للتأويل وهذا لا بد من بسطه
فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العاديات الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة الخائضين في لجتها العظمى العالمين بمواردها ومصادرها
والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفا بل كل على الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق :
أحدها : أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ـ ولم يبلغ تلك الدرجة ـ فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع وتارة يكون في كل أصل من أصول الدين ـ كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العملية ـ فتارة آخذا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها ما ظهر له بادىء رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها وهذا هو المبتدع وعليه نبه الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه و سلم قال :
[ لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم إتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ]
قال بعض أهل العلم : تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل : ما خان أمين قط ولكنه ائتمن غير أمين فخان قال ونحن نقول : ما ابتدع عالم قط ولكنه استفتى من ليس بعالم
قال مالك بن أنس : بكى ربيعة يوما بكاء شديدا فقيل له : مصيبة نزلت بك ؟ فقال لا ! ولكن استفتى من لا علم عنده
وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ قبل الساعة سنون خداعا يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق ويخون فيهن الأمين ويؤتمن الخائن وينطق فيهن الرويبضة ] قالوا : هو الرجل التافة الحقير ينطق في أمور العامة كأنه ليس بأهل أن يتكلم في أمور العامة فيتكلم
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قد علمت متى يهلك الناس ! إذا جاء الفقه من قبل الصغير عليه الكبير وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا
واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار فقال ابن المبارك : هم أهل البدع وهو موافق لأن أن أهل البدع أصاغر في العلم ولأجل ذلك صاروا أهل بدع
وقال الباجي : يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده قال : وقد كان عمر يستشير الصغار وكان القراء أهل مشاورته كهولا وشبانا قال : ويحتمل أن يريد بالأصاغر من لا قدر له ولا حال ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة فأما من التزمهما فلا بد أن سمو أمره ويعظم قدره
ومما يوضح هذا التأويل ما خرجه ابن وهب بسند مقطوع عن الحسن قال : العامل على غير علم كالسائر على غير طريق والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بترك العبادة واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بترك العلم فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه و سلم ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا ـ يعني الخوارج ـ والله أعلم لأنهم قرؤوا القرآن ولم يتفقهوا فيه حسبما أشار إليه الحديث
[ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ]
وروي عن مكحول أنه قال : تفقه الرعاع فساد الدين والدنيا وتفقه السفلة فساد الدين
وقال الفريابي : كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم تغير وجهه فقلت : يا أبا عبد الله ! أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك قال : كان العلم في العرب وفي سادات الناس وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء النبط والسفلة غير الدين
وهذه الآثار أيضا إذا حملت على تأويل المتقدم استدت واستقامت لأن ظواهرها مشكلة ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين أو أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا الأمم ومن ليس له أصالة في اللسان العربي فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجهه كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها
والثاني من أسباب الخلاف إتباع الهوى
ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها بل قدموا أهوءاهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم ويدخل في غمارهم من كان منهم يخشى السلاطين لنيل ما عندهم أو طلبا للرياسة فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم ويتأول عليهم فيما أرادوا حسبما ذكره العلماء ونقله من مصاحبي السلاطينفالأولون ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة بعقلوهم وأساؤوا الظن بما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة حتى ردوا كثيرا من أمور الآخرة وأحوالها من الصراط والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب الجسمي وأنكروا رؤية الباري وأشباه ذلك بل صيروا العقل شارعا جاء الشرع أو لا بل إن جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل إلى غير ذلك من الشناعات
والآخرون خرجوا عن الجادة إلى البينات وإن كانت مخالفة لطلب الشريعة حرصا على أن يغلب عدوه أو يفيد وليه أو يجر إلى نفسه نفعا كما ذكروا عن محمد بن يحيى بن لبابة أخي الشيخ ابن لبابة المشهور فإنه عزل عن قضاء ألبيرة ثم عزل عن الشورى لأشياء نقمت عليه وسجل بسخطته القاضي حبيب بن زيادة وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته وأن لا يفتي أحدا
ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر فشكا إلى القاضي ابن بقي ضرورته إليه لمقابلته منزهة وتأذية برؤيتهم أو أن تطلعه من علالية فقال له ابن بقي : لا حيلة عندي فيه وهو أولى أن يحاط بحرمة الحبس فقال له : تكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي وما أجزله من أضعاف القيمة فيه فلعلهم أن يجدوا لي في ذلك رخصة فتكلم ابن بقي معهم فلم يجدوا إليه سبيلا فغضب الناصر عليهم وأمر الوزراء بالتوجيه فيهم إلى القصر وتوبيخهم فجرت بينهم وبين بعض الوزراء مكالمة ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده
وبلغ ابن لبابة هذا الخبر فدفع إلى الناصر بعضا من أصحابه الفقهاء ويقول : إنهم حجروا عليه واسعا ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعارضة وتقلد حقا وناظر أصحابه فيها فوقع الأمر بنفس الناصر وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته الأولى ثم أمر القاضي بإعادة المشورة في المسألة فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء ابن لبابة آخرهم وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم من أجلها وغبطة المعارضة
فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه ـ وابن لبابة ساكت ـ فقال له القاضي : ما تقول أنت يا أبا عبد الله ؟ قال : أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلا وهم علماء أعلام يقتدى بهم أكثر الأمة وإذا بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به فما ينبغي أن يرد عنه وله في السنة فسحة وأنا أقول بقول أهل العراق وأتقلد ذلك رأيا
فقال له الفقهاء : سبحان الله ! تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنهم بوجه وهو رأي أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه ؟ فقال لهم محمد بن يحيى : ناشدتكم الله العظيم ! ألم تنزل بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بغير قول مالك في خاصة أنفسكم وأرخصتم لأنفسكم في ذلك ؟ قالوا : بلى ! قال : فأمير المؤمنين أولى بذلك فخذوا به مأخذكم وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فكلهم قدوة فسكتوا فقال للقاضي : أنه إلى أمير المؤمنين فتياي
فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب بأن يؤخذ له بفتيا محمد بن لبابة وينفذ ذلك ويعوض المرضى من هذا المجشر بأملاك ثمينة عجيبة وكانت عظيمة القدر جدا تزيد أضعافا على المجشر ثم جيء بكتاب من عند أمير المؤمنين منه إلى ابن لبابة بولاية خطة الوثائق ليكون هو المتولي لعقد هذه المعارضة فهنىء بالولاية وأمضى القاضي الحكم بفتواه وأشهد عليه وانصرفوا فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشورى إلى أن مات سنة 336 ست وثلاثين وثلاثمائة
قال القاضي عياض : ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر فقال : ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطة فهو أولى وأشد في السخطة مما تضمنه ـ أو كما قال
فتأملوا كيف اتباع الهوى وأولى أن ينتهي بصاحبه فشأن مثل هذا لا يحل أصلا من وجهين :
احدهما : أنه لم يتحقق المذهب الذي حكم به لأن أهل العراق لا يبطلون الإحباس هكذا على الإطلاق ومن حكى عنهم ذلك فإما على غير تثبيت وإما أنه كان قولا لهم رجعوا عنه بل مذهبهم يقرب من مذهب مالك حسبما هو مذكور في كتب الحنفية
والثاني : أنه إن سلمنا فلا يصح للحاكم أن يرجع في حكمه في أحد القولين بالمحبة والإمارة أو قضاء الحاجة إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا وهذا متفق عليه بين العلماء فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق أو رجح بغير معنى فقد خلع الربقة واستند إلى غير شرع عافانا الله من ذلك بفضله
فهذه الطريقة في الفتيا من جملة البدع المحدثات في دين الله تعالى كما أن تحكيم العقل على الدين مطلقا محدث وسيأتي بيان ذلك بعد إن شاء الله
وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهوى وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم قال الله تعالى : { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ } ـ أي ميل عن الحق ـ { فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله } وقد تقدم معنى الآية فمن شأنهم أن يتركوا الواضح ويتبعوا المتشابه عكس ما عليه الحق في نفسه
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ـ وذكرت الخوارج وما يلقون في القرآن فقال : يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه وقرأ ابن عباس الآية خرجه ابن وهب
وقد دل على ذمة القرآن في قوله : { أفرأيت من اتخذ إلهه هواه } الآية ولم يأت في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم حكى ابن وهب عن طاوس أنه قال : ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه وقال : { ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله } إلى غير ذلك من الآيات وحكى أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي أن رجلا سأل إبراهيم النخعي عن الأهواء : أيها خير ؟ فقال : ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول يعني ما كان عليه السلف الصالح
وخرج عن الثوري أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال : أنا على هواك فقال له ابن عباس : الهوى كله ضلالة : أي شيء انا على هواك ؟
والثالث من أسباب الخلاف التصميم على إتباع العوائد وإن فسدت أو كانت
مخالفة للحقوهو إتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك وهو التقليد المذموم فإن الله ذم بذلك في كتابه بقوله : { إنا وجدنا آباءنا على أمة } الآية ثم قال : { قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون } وقوله : { هل يسمعونكم إذ تدعون * أو ينفعونكم أو يضرون } فنبههم على وجه الدليل الواضح فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء فقالوا : { بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون } وهو مقتضى الحديث المتقدم أيضا في قوله :
[ اتخذ الناس رؤساء جهالا ] إلى آخره فإنه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان
وفيما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إياكم والاستنان بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء فهو إشارة إلى الأخذ بالاحتياط في الدين وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد على عمل أحد البتة حتى يتثبت فيه ويسأل عن حكمه إذ لعل المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة ولذلك قيل : لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك وقالوا : ضعف الروية أن يكون رأى فلانا يعمل مثله ولعله فعله ساهيا وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة وما أشبه ذلك لأنه دليل ثابت عند جماعة من العلماء على وجه ليس مما نحن فيه
وقول علي رضي الله عنه : فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات نكتة في الموضع
يعني الصحابة ومن جرى مجراهم ممن يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواه وأما غيرهم ممن لم يحل ذلك المحل فلا كأن يرى الإنسان رجلا يحسن اعتقاده فيه فيفعل فعلا محتملا أن يكون مشروعا أو غير مشروع فيقتدى به على الإطلاق ويعتمد عليه في التعبد ويجعله حجة في دين الله فهذا هو الضلال بعينه وما لم يتثبت بالسؤال والبحث عن حكم الفعل ممن هو أهل الفتوى
وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة إذا اتفق أن ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء فيراه يعمل عملا فيظنه عبادة فيقتدى به كائنا ما كان ذلك العمل موافقا للشرع أو مخالفا ويحتج به على من يرشده ويقول : كان الشيخ فلان من الأولياء وكان يفعله وهو أولى أن يقتدى به علماء الظاهر فهو في الحقيقة راجع إلى تقليد من حسن ظنه فيه أخطأ أو أصاب كالذين قلدوا آباءهم سواء وإنما قصارى هؤلاء أن يقولوا : إن آباءنا أو شيوخنا لم يكونوا ينتحلون مثل هذه الأمور سدى
وما هي إلا مقصودة بالدلائل والبراهين مع أنهم يرون أن لا دليل عليها ولا برهان يقود إلى القول بها
فصل هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد
هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد : وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت أو الأخذ فيها بالنظر الأول ولا يكون ذلك من راسخ في العلم ألا ترى إلى أن الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم وصفهم :بأنهم يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني ـ والله أعلم ـ أنهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قولبهم لأن الفهم راجع إلى القلب فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف فقط وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم وما تقدم أيضا من قوله عليه الصلاة و السلام : [ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ] إلى آخره
وقد وقع لابن عباس تفسير ذلك على معنى ما نحن فيه فخرج أبو عبيد في فضائل القرآن و سعيد بن منصور في تفسيره عن إبراهيم التميمي قال : خلا عمر رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه : كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد ؟ فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال : كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة ـ زاد سعيد وكتابها واحد ـ قال فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين : إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل فيكون لكل قوم فيه رأي فإذا كان كذلك اختلفوا وقال سعيد : فيكون لكل قوم رأي فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا قال : فزجره عمر وانتهره علي فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل إليه وقال : أعد علي ما قلته فأعاد عليه فعرف عمر قوله وأعجبه
وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الحق فإنه إذا عرف الرجل فيما نزلت الآية أو السورة عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بها فلم يتعد ذلك فيها وإذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أوجها فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخر وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى الصواب أو يقف بهم دون اقتحام حمى المشكلات فلم يكن بد من الأخذ ببادىء الرأي أو التأويل بالتخرص الذي لا يغني من الحق شيئا إذ لا دليل عليه من الشريعة فضلوا وأضلوا
ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا : كيف رأي ابن عمر في الحرورية ؟ قال : يراهم شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال : مما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } ويقرنون معها : { ثم الذين كفروا بربهم يعدلون } فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا : قد كفر ومن كفر عدل بربه ومن عدل بربه فقد أشرك فهؤلاء مشركون خرجوا على الأمة يقتلون ما يرونه مخالفا لهم لأنهم يتأولون هذه الآية فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس وهو الناشىء عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن
فإن قيل : فرضت الاختلاف المتكلم عنه في واسطة بين طرفين فكان من الواجب أن تردد النظر فيه عليهما فلم تفعل بل رددته إلى الطرف الأول في الذم والضلال ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا يضير وهو الاختلاف في الفروع
فالجواب عن ذلك : أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج إلى بيانه إلا من الجهة التي ذكرنا أما الجهة الأخرى فإن عدم ذكرهم في هذه الآمة وإدخالهم فيها أوضح أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول وإلا فلو كان ملحقا لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرقة ولا أخبر الشارع به ولا نبه السلف الصالح عليه فكما أنه لو فرضنا اتفاق الخلق على الملة بعد [ ما ] كانوا مفارقين لها لم نقل : اتفقت الأمة بعد اختلافها كذلك لا نقول : اختلفت الأمة وافترقت الأمة بعد اتفاقها أو خرج بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام وإنما يقال : افترقت وتفترق الأمة إذا كان الافتراق واقعا فيها مع بقاء اسم الأمة هذا هو الحقيقة ولذلك [ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخوارج : يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ] ثم قال : [ وتتمارى في الفوق ] وفي رواية :
[ فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة : هل علق بها من الدم شيء ] و [ التمارى في الفوق ] فيه هل فيه فرث ودم أم لا ؟ شك بحسب التمثيل : هل خرجوا من الإسلام حقيقة ؟ وهذه العبارة لا يعبر بها عمن خرج من الإسلام بالارتداد مثلا
وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم ألا ترى إلى صنع علي رضي الله عنه في الخوارج ؟ وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما } فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم يهيجهم علي ولا قاتلهم ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم لقوله عليه الصلاة و السلام :
[ من بدل دينه فاقتلوه ] ولأن أبا بكر رضي الله عنه خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم فدل ذلك على اختلاف ما بين المسألتين
وأيضا فحين ظهر معبد الجهني وغيره من أهل القدر لم يكن من السلف الصالح لهم إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران ولو كانوا خرجوا إلى كفر محض لأقاموا عليهم الحد المقام على المرتدين وعمر بن عبد العزيز أيضا لما خرج في زمانه الحرورية بالموصل أمر بالكف عنهم على ما أمر به علي رضي الله عنه ولم يعاملهم معاملة المرتدين
ومن جهة المعنى ! إنا وإن قلنا : إنهم متبعون الهوى ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفارا إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عنادا وهو كفر وأما من صدق الشريعة ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه مبتع للدليل يمثله لا يقال : إنه صاحب هوى بإطلاق بل هو متبع للشرع في نظره لكن بحيث يمازجه الهوى في مطالبه من جهة إدخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة
وأيضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على الجماعة من مطلب واحد وهو الانتساب إلى الشريعة ومن أشد مسائل الخلاف ـ مثلا ـ مسألة إثبات الصفات حيث نفاها من نفاها فإنا إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائما حول حمى التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث وهو مطلوب الأدلة وإنما وقع اختلافهم في الطريق وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين معا فحصل في هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع ؟
وأيضا فقد يعرض الدليل على المخالف منهم فيرجع إلى الوفاق لظهوره عنده كما رجع من الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه ألفان وإن كان الغالب عدم الرجوع كما تقدم في أن المبتدع ليس له توبة
حكى ابن عبد البر بسند يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي جعل يأتيه الرجل فيقول : يا أمير المؤمنين ! إن القوم خارجون عليك قال : دعهم حتى يخرجوا فلما كان ذات يوم قلت : يا أمير المؤمنين ! أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم ـ قال ـ فدخلت عليهم وهو قائلون فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم ثفن الإبل عليهم قمص مرخصة فقالوا : ما جاء بك با بن عباس ؟ وما هذه الحلة عليك ؟ ـ قال ـ قلت : ما تعيبون من ذلك ؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وعليه أحسن ما يكون من الثياب اليمنية ـ قال ـ ثم قرأت هذه الآية : { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق } فقالوا : ما جاء بك ؟ قال : جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وليس فيكم منهم أحد ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله جئت لأبلغكم عنهم وأبلغكم عنكم فقال بعضهم : لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول : { بل هم قوم خصمون } فقال بعضهم : بلى ! فلنكلمه ـ قال ـ فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة ـ قال ـ قلت ماذا نقمتم عليه ؟ قالوا : ثلاثا فقلت : ما هن ؟ قالوا : حكم الرجال في أمر الله وقال الله تعالى : { إن الحكم إلا لله } ـ قال ـ هذه واحدة ماذا أيضا ؟ قالوا : فإنه قاتل فلم سب ولم يغنم فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم ـ قال ـ قلت : وماذا أيضا ؟ قالوا : ومحا نفسه من إمرة المؤمنين فإن لم يكن امير المؤمنين فهو أمير الكافرين ـ قال ـ قلت أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله بما ينقض قولكم هذا أترجعون ؟ قالوا : وما لنا لا نرجع ؟
قال ـ قلت ـ أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإن الله قال في كتابه : { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم } وقال في المرأة وزوجها : { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } فصير الله ذلك إلى حكم الرجال فناشدتكم الله ! أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمنه ربع درهم ؟ وفي بضع امرأة ؟ قالوا : بلى ! هذا أفضل : قال : أخرجتم من هذه ؟ قالوا : نعم !
قال وأما قولكم : قاتل ولم سب ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة ؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم فأنتم ترددون بين ضلالتين اخرجتم من هذه ؟ قالوا : بلى !
قال : وأما قولكم : محا نفسه من إمرة المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون [ إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اكتب يا علي : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو : ما نعلم أنك رسول الله ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك قال رسول الله : اللهم إنك تعلم أني رسولك يا علي اكتب : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو قال : فرجع منهم ألفان وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعون ]
فصل حديث تفرق الأمة
صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتتفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ] وخرجه الترمذي هكذاوفي رواية أبي داود قال :
[ افترق اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ]
وفي الترمذي تفسير هذا ولكن بإسناد غريب عن غير أبي هريرة رضي الله عنه فقال في حديث :
[ وإن بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي ]
وفي سنن أبي داود :
[ وأن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعين في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة ] وهي بمعنى الرواية التي قبلها إلا أن هنا زيادة في بعض الروايات : [ وأنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ]
وفي رواية عن ابن أبي غالب موقوفا عليه :
[ إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم ] وفي رواية مرفوعا :
[ ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال ]
وهذا الحديث بهذه الرواية الأخيرة قدح فيه ابن عبد البر لأن ابن معين قال : إنه حديث باطل لا أصل له شبه فيه على نعيم حماد قال بعض المتأخرين : إن الحديث قد روي عن جماعة من الثقات ثم تكلم في إسناده بما يقتضي أنه ليس كما قال ابن عبد البر ثم قال : وفي الجملة فإسناده في الظاهر جيد إلا أن يكون ـ يعني ابن معين ـ قد اطلع منه على علة خفية
وأغرب من هذا كله رواية رأيتها في جامع ابن وهب
[ إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وثمانين ملة وستفترق أمتي على اثنتين وثمانين ملة كلها في النار إلا واحدة قالوا : وما هي يا رسول الله ؟ قال : ـ الجماعة ]
فإذا تقرر هذا تصدى النظر في الحديث في مسائل :
المسالة الأولى في حقيقة هذا الإفتراق
وهو يحتمل أن يكون افتراقا على ما يعطيه مقتضى اللفظ ويحتمل أم يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه ولكن يحتمله كما كان لفظ الرقبة بمطلقها لا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة لكن اللفظ يقبله فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق بحيث يطلق صور لفظ الاختلاف على معنى واحد لأنه يلزم أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ وذلك باطل بالإجماع فإن الخلاف من زمان الصحابة إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين ثم في سائر الصحابة ثم التابعين ولم يعب أحد ذلك منهم وبالصحابة اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف فكيف أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه الحديث ؟ وإنما يراد افتراق مقيد وإن لم يكن في الحديث نص عليه ففي الآيات مما يدل عليه قوله تعالى : { ولا تكونوا من المشركين * من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون } وقوله تعالى : { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء } وما أشبه ذلك الآيات الدالة على التفرق الذي صاروا به شيعا ومعنى صاروا شيعا أي جماعات بعضهم قد فارق البعض ليسوا على تآلف ولا تعاضد ولا تناصر بل على ضد ذلك فإن الإسلام واحد وأمره واحد فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على الاختلافوهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء ولذلك قال :
{ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا } فبين أن التأليف إنما يحصل عند الاتئلاف على التعلق بمعنى واحد وأما إذا تعلقت كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق وهو معنى قوله تعالى : { وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله }
وإذا ثبت هذا نزل عليه لفظ الحديث واستقام معناه والله أعلم
المسألة الثانية إن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العدواة
والبغضاء فإما أن يكون راجعا إلى أمر هو معصية غير بدعةإن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العدواة والبغضاء فإما أن يكون راجعا إلى أمر هو معصية غير بدعة ومثاله أن يقع بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنيوي كما يختلف مثلا أهل قرية مع قرية أخرى بسبب تعد في مال أو دم حتى تقع بينهم العدواة فيصيروا حزبين أو يختلفون في تقديم وال أو غير ذلك فيفترقون ومثل هذا محتمل وقد يشعر به
[ من فارق الجماعة قيد شبر فميتته جاهلية ] وفي مثل هذا جاء في الحديث :
[ إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما ] وجاء في القرآن الكريم : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما } إلى آخر القصة
وأما أن يرجع إلى أمر هو بدعة كما افترق الخوارج من الأمة ببدعهم التي ينوا عليها في الفرقة وكالمهدي المغربي الخارج عن الأمة نصرا للحق في زعمه فابتدع أمورا سياسية وغيرها خرج بها عن السنة ـ كما تقدمت الإشارة إليه قبل ـ وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة والأحاديث لمطابقتها لمعنى الحديث وأما أن يراد المعنيان معا
فأما الأول فلا أعلم قائلا به وإن كان ممكنا في نفسه إذ لم أر أحدا خص هذه بما إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنيوي لا بسبب بدعة وليس ثم دليل يدل على التخصيص لأن قوله عليه الصلاة و السلام : [ من فارق الجماعة قيد شبر ] الحديث لا يدل على الحصر وكذلك : [ إذ بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما ] وقد اختلف الفرقة في المراد بالجماعة المذكورة في الحديث حسبما يأتي فلم يكن منهم قائل بأن الفرقة المضادة للجماعة هي فرقة المعاصي غير البدع على الخصوص
وأما الثاني : وهو أن يراد المعنيان معا فلذلك أيضا ممكن إذ الفرقة المنبه عليها قد تحصل بسبب أمر دنيوي لا مدخل فيها للبدع وإنما هي معاص ومخالفات كسائر المعاضي وإلى هذا المعنى يرشد قول الطبري في تفسير الجماعة ـ حسبما يأتي بحول الله ـ ويعضده حديث الترمذي :
[ ليأتين على أمتي من يصنع ذلك ] ( ؟ ) فجعل الغاية في اتباعهم ما هو معصية كما ترى
وكذلك في الحديث الآخر :
[ لتتبعن سنن من كان قبلكم ـ إلى قوله ـ حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموهم ] فجعل الغاية ما ليس ببدعة
وفي معجم البغوي عن جابر رضي الله عنه [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه : أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء ـ قال : وما إمارة السفهاء ؟ ـ قال أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم ويردون علي الحوض ] الحديث
وكل من لم يهتد بهيده ولا يستن بسنته فإما إلى بدعة أو معصية فلا اختصاص بأحدهما غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة المذكورة إنما هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص وعلى ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء ولم يعدوا منها المفترقين بسبب المعاصي التي ليست بدع وعلى ذلك يقع التفريع إن شاء الله
المسألة الثالثة : إن هذه الفرق يحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن
الملةإن هذه الفرقة تحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب ما أحدثوا
فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق وليس ذلك إلا لكفر إذ ليس بين المنزلتين منزلة ثالثة تتصور
ويدل على هذا الاحتمال ظواهر من القرآن والسنة كقوله تعالى : { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء } وهي آية نزلت ـ عند المفسرين ـ في أهل البدع ويوضحه من قرأ : { إن الذين فرقوا دينهم } والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما هي الخروج عنه وقوله : { فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم } الآية وهي عند العلماء منزلة في أهل القبلة وهم أهل البدع وهذا كالنص إلى غير ذلك من الآيات
وأما الحديث فقوله عليه الصلاة و السلام : [ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ] وهذا نص في كفر من قبل ذلك فيه وفسره الحسن بما تقدم في قوله
[ ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ] الحديث وقوله عليه الصلاة و السلام في الخوارج :
[ دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء ـ وهو القدح ـ ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء من الفرث والدم ] فانظر إلى قوله : [ من الفرث والدم ] فهو الشاهد على أنهم دخلوا في الإسلام فلا يتعلق بهم منه شيء
وفي رواية أبي ذر رضي الله عنه :
[ سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة ] إلى غير ذلك من الأحاديث إنما هي قوم بأعيانهم فلا حجة فيها على غيرهم لأن العلماء استدلوا بها على جميع أهل الأهواء كما استدلوا بالآيات
وأيضا فالآيات إن دلت بصيغ عمومها فالأحاديث تدل بمعانيها لاجتماع الجميع في العلة
فإن قيل : الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى حكم الآخرة والقياس لا يجري فيها فالجواب : إن كلا منا في الأحكام الدنيوية وهل يحكم لهم بحكم المرتدين أم لا ؟ وإنما أمر الآخرة لله لقوله تعالى : { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون }
ويحتمل أن لا يكونوا خارجين عن الإسلام جملة وإن كانوا قد خرجوا عن جملة من شرائعه وأصوله
ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما قبل هذا الفصل فلا فائدة في الإعادة
ويحتمل وجها ثالثا وهو أن يكون منهم من فارق الإسلام لكن مقالته كفر وتؤدي معنى الكفر الصريح ومنهم من لم يفارقه بل انسحب عليه حكم الإسلام وإن عظم مقالة وشنع مذهبه لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى الكفر المحض والتبديل الصريح
ويدل على ذلك الدليل بحسب كل نازلة وبحسب كل بدعة إذ لا شك في أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر كاتخاذ الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة عند جماعة وإنكار الإجماع وإنكار القياس وما أشبه ذلك
ولقد فصل بعض المتأخرين في التكفير تفصيلا في هذه الفرق فقال : ما كان من البدع راجعا إلى اعتقاد وجود إله مع الله كقوله السبئية في علي رضي الله عنه إنه إله أو خلق الإله في بعض أشخاص الناس كقول الجناحية : إن الله تعالى له روح يحل في بعض بني آدم ويتوارث أو إنكار رسالة محمد صلى الله عليه و سلم كقول الغرابية : إن جبريل غلط في الرسالة فأذاها إلى محمد صلى الله عليه و سلم وعلي كان صاحبها أو استباحة المحرمات وإسقاط الواجبات وإنكار ما جاء به الرسول كأكثر الغلا ة من الشيعة مما لا يختلف المسلمون في التكفير به وما سوى ذلك من المقالات فلا يبعد أن يكونوا معتقدها غير كافر
واستدل على ذلك بأمور كثيرة لا حاجة إلى إيرادها ولكن الذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب المحققين من أهل الأصول إن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفة به تبني له وجه لزوم الكفر من مقالته لم يقل بها على حال
وإذا تقرر نقل الخلاف فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن بصدده من هذه المقالات
أما ما صح منه فلا دليل على شيء لأنه ليس فيه إلا تعديد الفرق خاصة وأما على رواية من قال في حديثه :
[ كلها في النار إلا واحدة ] فإنما يقتضي إنفاذ الوعيد ظاهرا ويبقى الخلود وعدمه مسكوتا عنه فلا دليل فيه على شيء مما أردنا إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين كما يتعلق بالكفار على الجملة وإن تباينا في التخليد وعدمه
المسألة الرابعة إن هذه الأقوال المذكورة آنفا مبنية على أن الفرق
المذكورة في الحديث هي المبتدعةإن هذه الأقوال المذكورة آنفا مبنية على أن الفرق المذكورة في الحديث هي المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص كالجبرية والقدرية والمرجئة وغيرها وهو مما ينظر فيه فإن إشارة القرآن والحديث تدل على عدم الخصوص وهو رأي الطرطوشي إفلا ترى إلى قوله تعالى : { فأما الذين في قلوبهم زيغ } و ما في قوله تعالى : { ما تشابه } لا تعطى خصوصا في اتباع المتشابه لا في قواعد العقائد ولا في غيرها بل الصيغة تشمل ذلك كله فالتخصيص تحكم
وكذلك قوله تعالى : { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء } فجعل ذلك التفريق في الدين ولفظ الدين ويشمل العقائد وغيرها وقوله : { وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله } فالصراط المستقيم هو الشريعة على العموم وشبه ما تقدم في السورة من تحريم ما ذبح لغير الله لغير الله وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره وإيجاب الزكاة كل ذلك على أبدع نظم وأحسن سياق
ثم قال تعالى : { قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا } فذكر أشياء من القواعد وغيرها فابتدأ بالنهي عن الإشتراك ثم الأمر ببر الوالدين ثم النهي عن قتل الأولاد ثم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم عن قتل النفس بإطلاق ثم عن أكل مال اليتيم ثم الأمر بتوفية الكيل والوزن ثم العدل في القول ثم الوفاء بالعهد
ثم ختم ذلك بقوله : { وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله }
فأشار إلى ما تقدم ذكره من أصول الشريعة وقواعدها الضرورية ولم يخص ذلك بالعقائد فدل على أن إشارة الحديث لا تختص بها دون غيرها
وفي حديث الخوارج ما يدل عليه أيضا فإنه ذمهم بعد أن ذكر أعمالهم وقال في جملة ما ذمهم به :
[ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ] فذمهم بترك التدبر والأخذ بظواهر المتشابهات كما قالوا : حكم الرجال في دين الله والله بقول : { إن الحكم إلا لله }
وقال أيضا :
[ ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ] فذمهم بعكس ما عليه الشرع لأن الشريعة جاءت بقتل الكفار والكف عن المسلمين وكلا الأمرين غير مخصوص بالعقائد
فدل على أن الأمر على العموم لا على الخصوص فيما رواه نعيم بن حماد في هذا الحديث :
[ أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال ] وهذا نص في أن ذلك العدد لا يختص بما قالوا من العقائد
واستدل الطرطوشي على أن البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن الصحابة والتابعين وسار العلماء من تسيتهم الأقوال والأفعال بدعا إذا خالفت الشريعة ثم أتى بآثار كثيرة كالذي رواه مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه قال : ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا لنداء بالصلاة يعني بالناس الصحابة وذلك أنه أنكر أكثر أفعال عصره ورآها مخالفة لأفعال الصحابة
وكذلك أبو الدراداء سأله رجل فقال : رحمك الله لو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا هلة ينكر شيئا مما نحن عليه ؟ فغضب واشتد غضبه ثم قال : وهل يعرف شيئا مما أنتم عليه ؟
وفي البخاري عن أم الدرداء قالت : دخل أبو الدرداء مغضبا فقلت له : ما لك ؟ فقال : والله ما اعرف منهم من أمر محمد أنهم يصلون جميعا وذكر جملة من أقاويلهم في هذا المعنى مما يدل على أن مخالفة السنة في الأفعال قد ظهرت
وفي مسلم قال مجاهد : دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر مستند إلى حجرة عائشة وإذا ناس في المسجد يصلون الضحى فقلنا : ما هذه الصلاة ؟ فقال : بدعة
قال الطرطوشي : فحمله عندنا على أحد وجهين : إنا أنهم يصلونها جماعة وإما أفذاذا على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض وذكر أشياء من البدع القولية مما نص العلماء على أنها بدع فصح أن البدع لا تختص بالعقائد وقد تقررت هذه المسألة في كتاب الموافقات بنوع آخر من التقرير
نعم ثم معنى آخر ينبغي أن يذكر هنا وهي :
المسألة الخامسة أن هذه الفرق إنما تصير فرقا لخلافها للفرقة الناجية
وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية لأن الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل وشاذها في الغالب أن لا يختص بمحل دون محل ولا بباب دون بابواعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال
ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا وأما الجزئي فبخلاف ذلك بل بعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ثلاث يهدمن الدين : زلة العالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للدين بخلاف الكليات
فأنت ترى موقع اتباع المتشابهات كيف هو في الدين إذا كان اتباعا مخلا بالواضحات وهي أم الكتاب وكذلك عدم تفهم القرآن موقع في الإخلال بكلياته وجزئياته
وقد ثبت أيضا للكفار بدع فرعية ولكنها في الضروريات وما قاربها كجعلهم لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائهم نصيبا ثم فرعوا عليه أن ما كان لشركائهم فلا يصل إلى اله وما كان لله وصل إلى شركائهم وتحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وقتلهم أولادهم سفها بغير علم وترك العدل في القصاص والميراث والحيف في النكاح والطلاق وأكل مال اليتيم على نوع من الحيل إلى أشباه ذلك مما نبه عليه الشرع وذكره العلماء حتى صار التشريع ديدنا لهم وتغيير ملة إبراهيم عليه السلام سهلا عليهم فأنشأ ذلك أصلا مضافا إليهم وقاعدة رضوا بها وهي التشريع المطلع لا الهوى ولذلك لما نبههم الله تعالى على إقامة الحجة عليهم بقوله تعالى : { قل آلذكرين حرم أم الأنثيين } قال فيها : { نبئوني بعلم إن كنتم صادقين } فطالبهم بالعلم الذي شأنه أن لا يشرع إلا حقا وهو علم الشريعة لا غيره ثم قال تعالى : { أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا } تنبيها لهم على أن هذا ليس مما شرعه في ملة إبراهيم : ثم قال : { فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم } فثبت أن هذه الفرق إنما افترقت بحسب أمور كلية اختلفوا فيها والله أعلم
المسألة السادسة إنا إذا قلنا بأن هذه الفرق كفار
إنا إذا قلنا بأن هذه الفرق كفار ـ على قول من قال به ـ أو ينقسمون إلى كافر وغيره فكيف يعدون من الأمة ؟ وظاهر الحديث يقتضي أن ذلك الافتراق إنما هو مع كونهم من الأمة وإلا فلو خرجوا من الأمة إلى الكفر لم يعدوا منها البتة ـ كما تبين :وكذلك الظاهر في فرق اليهود والنصارى إن التفرق فيهم حاصل مع كونهم هودا ونصارى ؟
فيقال في الجواب عن هذا السؤال : إنه يحتمل أمرين :
أحدهما : أنا نأخذ الحديث على ظاهره في كون هذه الفرق من الأمة ومن أهل القبلة ومن قيل بكفره منهم فإما أن يسلم فيهم هذا القول فلا يجعلهم من الأمة أصلا ولا أنهم مما يعدون في الفرق وإنما نعد منهم من لا تخرجه بدعته إلى كفر فإن قال بتكفيرهم جميعا فلا يسلم أنهم المرادون بالحديث على ذلك التقدير وليس في حديث الخوارج نص على أنهم من الفرق الداخلة في الحديث بل نقول : المراد بالحديث فرق لا تخرجهم بدعهم عن الإسلام فليبحث عنهم
وإما أن لا نتبع المكفر في إطلاق القول بالتكفير ونفصل الأمر إلى نحو مما فصله صاحب القول الثالث ويخرج من العدد من حكمنا بكفره ولا يدخل تحت عمومه إلا ما سواه مع غيره ممن لم يذكر في تلك العدة
والإحتمال الثاني : أن نعدهم من الأمة على طريقة لعلها تتمشى في المواضع وذلك أن كل فرقة تدعي الشريعة وأنها على صوبها وأنها المتبعة للمتبعة لها وتتمسك بأدلتها وتعمل على ما ظهر لها من طريقها ! وهي تناصب العداوة من نسبتها إلى الخروج عنها وترمي بالجهل وعدم العلم من ناقضها لأنها تدعي أن ما ذهبت إليه هو الصراط المستقيم دون غيره وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام لأن المرتد إذا نسبته إلى الارتداد أقر به ورضيه ولم يسخطه ولم يعادل لتلك النسبة كسائر اليهود والنصارى وأرباب النحل المخالفة للإسلام
بخلاف هؤلاء الفرق فإنهم مدعون الموالفة للشارع والرسوخ في اتباع شريعة محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم فإنما وقعت العداوة بينهم وبين أهل السنة بسبب ادعاء بعضهم على بعض الخروج عن السنة ولذلك تجدهم مبالغين في العمل والعبادة حتى بعض أشد الناس عبادة مفتون
والشاهد لهذا كله ـ مع اعتبار الواقع ـ حديث الخوارج فإنه قال عليه الصلاة و السلام : [ تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم ] وفي رواية :
[ يخرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن ليست قراءتكم من قراءتهم بشيء ولا صلاتكم من صلاتهم بشيء ] وهذه شدة المثابرة على العمل به ومن ذلك قولهم كيف يحكم الرجال والله يقول : { إن الحكم إلا لله } ؟ ففي ظنهم أن الرجال لا يحكمون بهذا الدليل ثم قال عليه الصلاة و السلام : [ يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم ]
فقوله عليه الصلاة و السلام : [ يحسبون أنه لهم ] واضح فيما قلنا ثم إنهم يطلبون اتباعه بتلك الأعمال ليكونوا من أهله وليكون حجة لهم فحين ابتغوا تأويله وخرجوا عن الجادة كان عليهم لا لهم
وفي معنى ذلك من قول [ ابن مسعود قال : وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتعمق عليكم بالعتيق ] فقوله : [ يزعمون ] كذا دليل على أنهم على الشرع فيما يزعمون
ومن الشواهد أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه : [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج إلى المقبرة فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ! وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا ـ قالوا : يا رسول الله ألسنا إخوانك ؟ ـ قال : بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطكم على الحوض قالوا : يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك ؟ قال : أرأيت لو كان لأحدكم خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فيذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم : ألا هلم ألا هلم ! فيقال قد بدلوا بعدك فأقول : فسحقا فسحقا فسحقا ]
فوجه الدليل من الحديث أن قوله : [ فيلذادن رجال عن حوضي ] إلى قوله : [ أناديهم ألا هلم ] مشعر بأنهم من أمته وأنه عرفهم وقد بين أنهم يعرفون بالغرر والتحجيل فدل على أن هؤلاء الذين دعاهم وقد كانوا بدلوا ذوو غرر وتحجيل وذلك من خاصية هذه الأمة فبأن أنهم معدودن من الأمة ولو حكم لهم بالخروج من الأمة لم يعرفهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بغرة أو تحجيل لعدمه عندهم
ولا علينا أقلنا : إنهم خرجوا ببدعتهم عن الأمة أو لا إذ أثبتنا لهم وصف الأنحياش إليها
وفي الحديث الآخر :
[ فيؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول : يا رب أصحابي ! قال : فيقال : لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح : { وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم } إلى قوله : { العزيز الحكيم } ـ قال ـ فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ]
فإن كان المراد بالصحابة الأمة فالحديث موافق لما قبله :
[ بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ] فلا بد من تأويله على أن الأصحاب يعني بهم من آمن بي في حياته وإن لم يره ويصدق لفظ المرتدين على أعقابهم بعد موته أو مانعي الزكاة تأويلا على أن أخذها إنما كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم وحده فإن عامة أصحابه رأوه وأخذوا عنه براءة من ذلك
المسألة السابعة في تعيين هذه الفرق
وهي مسألة ـ كما قال الطرطوشي ـ طاشت فيها أحلام الخلق فكثير ممن تقدم وتأخر من العلماء عينوها لكن في الطرائف التي خالفت في مسائل العقائد فمنهم من عد أصولها ثمانية فقال : كبار الفرق الإسلامية ثمانية : ( 1 ) المعتزلة و ( 2 ) الشيعة و ( 3 ) الخوارج و ( 4 ) المرجئة و ( 5 ) النجارية و ( 6 ) الجبرية و ( 7 ) المشبهة و ( 8 ) الناجيةفأما المعتزلة فافترقوا إلى عشرين فرقة وهم : الواصلية والعمرية والهذيلية والنظامية والأسوارية والإسكافية والجعفرية والبشرية والمزدارية والهشامية والصالحية والخطابية والحدبية والمعمرية والثمامية والخياطية والجاحظية والكعبية والجبائية والبهشمية
وأما الشيعة فانقمسوا أولا ثلاث فرق : غلاة وزيدية وإمامية
فالغلاة ثمان عشرة فرقة وهم : السبئية والكاملية والبيانية والمغيرية والجناحية والمنصورية والخطابية والغرابية والذمية والهشامية والزرارية واليونسية والشيطانية والرزامية والمفوضة والبدائية والنصيرية والإسماعيلية وهم : الباطنية والقرمطية والخرمية والسبعية والبابكية والحمدية
وأما الزيدية فهم ثلاث فرق : الجارودية والسليمانية والبتيرية
وأما الإمامية ففرقة واحدة فالجميع اثنتان وأربعون فرقة
وأما الخوارج فسبع فرق وهم : المحكمة والبيهسية والأزارقة والنجدات والعبدية والأباضية وهم أربع فرق : الحفصية واليزيدية والحارثية والمطيعية
وأما العجاردة فإحدى عشرة فرقة وهم : الميمونة والشعيبية والحازمية والحمزية والمعلومية والمجهولية والصلتية والثعلبية أربع فرق وهم : الأخنسية والمعبدية والشيبانية والمكرمية فالجميع اثنتان وستون
وأما المرجئة فخمس وهم : العبيدية واليونسية والغسانية والثوبانية والثومنية
وأما النجارية فثلاث فرق وهم : البرغوثية والزعفرانية والمستدركة
وأما الجبرية ففرقة واحدة وكذلك المشبهة
فالجميع اثنتان وسبعون فرقة فإذا أصبغت الفرقة الناجية إلى عدد الفرق صار الجميع ثلاثا وسبعين فرقة
وهذا التعديد بحسب ما اعطته المنة في تكلف المطابقة للحديث الصحيح لا على القطع بأنه المراد إذ ليس على ذلك دليل شرعي ولا دل العقل أيضا على إنحصار ما ذكر في تلك العدة من غير زيادة ولا نقصان كما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع وقال جماعة من العلماء : أصول البدع أربعة وسائر الثنتين والسبعين فرقة عن هؤلاء تفرقوا وهم : الخوارج والرواقض والقدرية والمرجئة
قال يوسف بن أسباط : ثم تشعبت كل فرقة ثمان عشرة فرقة : فتلك اثنتان وسبعون فرقة والثالثة والسبعون هي الناجية
وهذا التقدير نحو الأول ويرد عليه من الإشكال ما ورد على الأول
فشرح ذلك الشيخ أبو بكر الطرطوشي رحمه الله شرحا يقرب الأمر فقال : لم يرد علماؤنا بهذا التقدير أن أصل كل بدعة من هذه الأربع تفرقت وتشعبت على مقتضى أصل البدع حتى تحملت تلك العدة لأن ذلك لعله لم يدخل في الوجود إلى الآن قال : وإنما أرادوا أن كل بدعة ضلالة لا تكاد توجد إلا في هذه الفرق الأربع وإن لم تكن البدعة الثانية فرعا للأولى ولا شعبة من شعبها بل هي بدعة مستقلة بنفسها ليست من الأولى بسبيل
ثم بين ذلك بالمثال بأن التقدير أصل من أصول البدع ثم اختلف أهله في مسائل من شعب القدر وفي مسائل لا تعلق لها بالقدر فجميعهم متفقون على أن أفعال العباد مخلوقة لهم من دون الله تعالى
ثم اختلفوا في فرع من فروع القدر فقال أكثرهم : لا يكون فعل بين فعلين مخلوقين على التولد أحال مثله بين القديم والمحدث
ثم اختلفوا فيما لا يعود إلى القدر في مسائل كثيرة كاختلافهم في الصلاح والأصلح : فقال البغداديون منهم : يجب على الله تعالى فعل الصلاح لعباده في دينهم
ويجب عليه ابتداء الخلق الذين علم أنه يكلفهم ويجب عليه إكمال عقولهم وإقدارهم وإزاحة عللهم
وقال البصريون منهم : لا يجب على الله إكمال عقولهم ولا أن يؤتيهم أسباب التكليف
وقال البغداديون منهم : يجب على الله ـ تعالى عن قولهم ـ عقاب العصاة إذا لم يتوبوا والمغفرة من غير توبة سفه من الغافر
وأما المضربون منهم ذلك
أحد الموطنين اللذين يجوز فيهما ذكر الفرق بأسمائها
وابتدع جعفر بن مبشر من استصر ( ؟ ) امرأة ليتزوجها فوثب عليها فوطئها بلا ولي ولا شهود ولا رضى ولا عقد حل له ذلك وخالفه في ذلك سلفهوقال ثمامة بن أشرس : إن الله يصير الكفار والملحدين وأطفال المشركين والمؤمنين والمجانين ترابا يوم القيامة لا يعذبهم ولا يعرضهم
وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعا تتعلق بأصل بدعتها التي هي معروفة بها وبدعا لا تعلق لها بها
فإن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أراد بتفرق أمته أصول البدع التي تجري مجرى الأجناس للأنواع والمعاقد للفروع لعلهم ـ والعلم عند الله ـ ما بلغن هذا العدد إلى الآن غير أن الزمان باق والتكليف قائم والخطرات متوقعة وهل قرن أو عصر يخلو إلا وتحدث فيه البدع ؟
وإن كان أراد بالتفرق كل بدعة حدثت في دين الإسلام مما لا يلائم أصول الإسلام ولا تقبلها قواعده من غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرنا كانت البدع أنواعا لأجناس أو كانت متغايرة الأصول والمباني
فهذا هو الذي أراده عليه الصلاة و السلام ـ والعلم عند الله ـ فقد وجد من ذلك عدد أكثر من اثنتين وسبعين
ووجه تصحيح الحديث على هذا أن تخرج من الحساب غلاة أهل البدع ولا يعدون من الأمة ولا في أهل القبلة كنفاة الأعراض من القدرية لأنه لا طريق إلى معرفة حدوث العالم وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض وكالحلولية والنصيرية وأشباههم من الغلاة
هذا ما قال الطرطوشي رحمه الله تعالى وهو حسن من التقرير غير أنه يبقى للنظر في كلامه مجلان :
أحدهما : أن ما اختار من ليس المراد الأجناس فإن كان مراده أعيان البدع وقد ارتضى اعتبار البدع القولية والعملية فمشكل لأنا إذا اعتبرنا كل بدعة دقت أو جلت فكل من ابتدع بدع كيف كانت لزم أن يكون هو ومن تابعه عليها فرقة فلا تقف في مائة ولا مائتين فضلا عن وقوعها في اثنتين وسبعين وأن البدع ـ كما قال ـ لا تزال تحدث مع مرور الأزمنة إلى قيام الساعة
وقد مر من النقل ما يشعر بهذا المعنى وهو قول ابن عباس : ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن وهذا موجود في الواقع فإن البدع قد نشأت إلى الآن ولا تزال تكثر وإن فرضنا إزالة بدع الزائغين في العقائد كلها لكان الذي يبقى أكثر من اثنتين وسبعين فما قاله ـ والله أعلم ـ غير مخلص
والثاني : أن حاصل كلامه أن هذه الفرق لم تتعين بعد بخلاف القول المتقدم وهو أصح في النظر لأن ذلك التعيين ليس عليه دليل والعقل لا يقتضيه وأيضا فالمنازع له أن يتكلف من مسائل الخلاف التي بين الأشعرية في قواعد العقائد فرقا يسميها ويبرىء نفسه وفرقته عن ذلك المحظور فالأولى ما قاله من عدم التعيين وإن سلمنا أن الدليل قام له على ذلك فلا ينبغي التعيين
أما أولا : فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصافهم من غير تصريح ليحذر منها ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مرجى وإنما ورد التعيين في النادر كما قال عليه الصلاة و السلام في الخوارج :
[ إن من ضئضىء هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ] الحديث مع أنه عليه الصلاة و السلام لم يعرف أنهم ممن شملهم حديث الفرق وهذا الفصل مبسوط في كتاب الموافقات والحمد لله
وأما ثانيا : فلأن عدم التعيين هو الذين ينبغي أن يلتزم ليكون سترا على الأمة كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا في الغالب وأمرنا بالستر على المؤمنين ما لم تبد لنا صفحة الخلاف ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلا أصبح وعلى بابه معصية مكتوبة وكذلك في شأن قربانهم : فإنهم كانوا إذا قربوا لله قربانا فإن كان مقبولا عند الله نزلت نار من السماء فأكلته وإن لم يكن مقبولا لم تأكله النار وفي ذلك افتضاح المذنب ومثل ذلك في الغنائم أيضا فكثير من هذه الأشياء خصت هذه الأمة بالستر فيها
وأيضا فللستر حكمة أخرى وهي أنها لو أظهرت مع أن أصحابها من الأمة لكان في ذلك داع إلى الفرقة وعدم الألفة التي أمر الله ورسوله بها حيث قال تعالى : { واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا } وقال تعالى : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } وقال تعالى : { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات } وفي الحديث :
[ لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا ] وأمر عليه الصلاة و السلام بإصلاح ذات البين وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الدين
فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة بينهم والفرقة لزم من ذلك أن يكون منهيا عنه إلا أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة الخوارج وذكرهم بعلامتهم حتى يعرفوا ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد وما عدا ذلك فالسكوت عنه أولى
وخرج أبو داود عن عمرو بن أبي قرة قال :
[ كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله لأناس من أصحابه في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان : حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون : قد ذكرنا قولك إلى سلمان فما صدقك ولا كذبك فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال : يا سلمان ! ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغضب فيقول لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضى : أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة ؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب فقال : أيما رجل سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني الله رحمة للعالمين إجعلها عليهم صلاة يوم القيامة فوالله لتنتهين أو أكتبن إلى عمر ]
فتأملوا ما أحسن هذا الفقه من سلمان رضي الله عنه ! وهو جار في مسألتنا فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول : هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان ! وإن كان يعرفهم بعلامتهم بحسب اجتهاده اللهم إلا في موطنين :
أحدهما : حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج فإنه ظهر من استقرائه أنهم متمكنون تحت حديث الفرق ويجري مجراهم من سلك سبيلهم فإن أقرب الناس إليهم شيعة المهدي المغربي فإنه ظهر فيهم الأمران اللذان عرف النبي صلى الله عليه و سلم بهما في الخوارج من أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فإنهم أخذوا أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه حتى ابتدعوا فيه ثم لم يتفقهوا فيه ولا عرفوا مقاصده ولذلك طرحوا كتب العلماء وسموها كتب الرأي وخرقوها ومزقوا أدمها مع أن الفقهاء هم الذين بينوا في كتبهم معاني الكتاب والسنة على الوجه الذي ينبغي وأخذوا في قتال أهل الإسلام بتأويل فاسد زعموا عليهم أنهم مجسمون وأنهم غير موحدين وتركوا الانفراد بقتال أهل الكفر من النصارى والمجاورين لهم وغيرهم
فقد اشتهر في الأخبار والآثار ما كان من خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى من بعده كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيرهم حتى لقد روي في حديث خرجه البغوي في معجمه عن حميد بن هلال أن عبادة بن قرط غزا فمكث في غزاته تلك ما شاء الله ثم رجع مع المسلمين منذ زمان فقصد نحو الأذان يريد الصلاة فإذا هو بالأزارقة ـ صنف من الخوارج ـ فلما رأوه قالوا : ما جاء بك يا عدو الله ؟ قال : ما أنتم يا إخوتي ؟ قالوا : أنت أخو الشيطان لنقتلنك قال ما ترضون مني بما رضي به رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قالوا : وأي شيء رضي به منك ؟ قال : أتيته وأنا كافر فشهدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله فخلى عني ـ قال ـ فأخذوه فقتلوه
وأما عدم فهمهم للقرآن فقد تقدم بيانه وقد جاء في القدرية حديث خرجه أبو داود عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ]
وعن حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة و السلام قال :
ثاني الموطنين اللذين يجوز فيهما ذكر الفرق بأسمائها
[ لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون : لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازتهم ومن مرض منهم فلا تعودوه وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال ] وهذا الحديث غير صحيح عند أهل النقل قال صاحب المغني : لم يصح في ذلك شيء نعم قول ابن عمر ليحيى بن يعمر حين أخبره أ ن القول بالقدر قد ظهر : إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم برآء مني ثم استدل :بحديث جبريل ـ صحيح لا إشكال في صحته
خرج أبو داود أيضا من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم ] ولم يصح أيضا
وخرج ابن وهب عن زيد بن علي قال :
[ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صنفان من أمتي لا سهم لهم في الإسلام يوم القيامة : المرجئة والقدرية ] و [ عن معاذ بن جبل وغيره يرفعه قال : لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا آخرهم محمد صلى الله عليه و سلم ] وعن مجاهد بن جبر :
[ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : سيكون من أمتي قدرية وزنديقية أولئك مجوس ]
وعن نافع قال : بينما نحن عند عبد الله بن عمر نعوده إذ جاء رجل فقال : إن فلانا يقرأ عليك السلام ـ لرجل من أهل الشام ـ فقال عبد الله : بلغني أنه قد أحدث حدثا فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : [ سيكون في أمتي مسخ وخسف وهو في الزنديقية ]
وعن ابن الديلمي قال : اتينا أبي كعب فقلت له : وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي فقال : لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار قال : ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال لي مثل ذلك قال : ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك وفي بعض الحديث :
[ لا تكلموا في القدر فإنه سر الله ] وهذا كله أيضا غير صحيح
وجاء في المرجئة والجهمية شيء لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا تعديل عليه
نعم نقل المفسرون أن قوله تعالى : { يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر * إنا كل شيء خلقناه بقدر } نزل في أهل القدر فروى عبد بن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
أتى مشركوا قريش إلى النبي صلى الله عليه و سلم يخاصمونه في القدر فنزلت الآية وروى مجاهد وغيره أنها نزلت في المكذبين بالقدر ولكن إن صح ففيه دليل وإلا فليس في الآية ما يعين أنهم من الفرق وكلامنا فيه
والثاني : حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس وهم من شياطين الإنس فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له الشهود على أنهم منهم كما اشتهر عن عمرو بن عبيد وغيره فروى عاصم الأحوال قال : جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منه فقلت : أبا الخطاب : ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض ؟ فقال : يا أحول أو لا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر ؟ فجئت من عند قتادة وأنا مغتم بما سمعت من قتادة في عمرو بن عبيد وما رأيت من نسكه وهديه فوضعت رأسي نصف النهار وإذا عمرو بن عبيد والمصحف في حجره وهو يحك آية من كتاب الله فقلت : سبحان الله ! تحك آية من كتاب الله ؟ قال إني سأعيدها قال : فتركته حتى حكها فقلت له : أعدها فقال : لا أستطيع
فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعدواة ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم ـ إذا أقيم ـ عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم وإذا تعارض الضرران يركتب أخفهما وأسهلهما وبعض الشر أهون من جميعه كقطع اليد المتآكلة إتلافها أسهل من إتلاف النفس وهذا شأن الشرع أبدا : يطرح حكم الأخف وقاية من الأثقل
فإذا فقد الأمران فلا ينبغي أن يذكروا لأن يعنيوا وإن وجدوا لأن ذلك أول مثير للشر وإلقاء العداوة والبغضاء ومتى حصل باليد منهم أحد ذاكره برفق ولم يره أنه خارج من السنة بل يريه أنه مخالف للدليل الشرعي وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذا فإن فعل ذلك من غير تعصب ولا إظهار غلبة فهو الحج وبهذه الطريقة دعي الخلق أولا إلى الله تعالى حتى إذا عاندوا وأشاعوا الخلاف وأظهروا الفرقة قوبلوا بحسب ذلك
قال الغزالي في بعض كتبه : أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهل أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلال ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستفزا في قلب مجنون فضلا عن قلب عاقل
هذا ما قال وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية فالواجب تسكين الثائرة ما قدر على ذلك والله أعلم
المسألة الثامنة أنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون
بها وهي على قسمين : علامات إجمالية وعلامات تفصيلية فأما الإجمالية فثلاث إحداها : الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى : ولا تكونوا كالذين تفرقواأنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون بها وهي على قسمين :
علامات إجمالية وعلامات تفصيلية
فأما العلامات الإجمالية فثلاث
إحداها : الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى : { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات } وقوله تعالى : { وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة } روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال : هي الجدال والخصومات في الدين وقوله تعالى : { واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا } وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وصدق الحديث ]
وهذا التفريق ـ كما تقدم ـ إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة الواحدة شيعا
قال بعض العلماء : صاروا فرقا لاتباع أهوائهم وبمفارقة الدين تشتت أهواؤهم فافترقوا وهو قوله تعالى : { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا } ثم برأه الله منهم بقوله :
{ لست منهم في شيء } وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله
قال : ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولم يتفرقوا ولا صاروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد إلى الرأي والإستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا واختلف في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد مع الأم وقول عمر وعلي في أمهات الأولاد وخلافهم في الفريضة المشتركة وخلافهم في الطلاق قبل النكاح وفي البيوع وغير ذلك فقد اختلفوا فيه وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة فلما حدثت الأهواء المردية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه و سلم وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعا دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه
قال : كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء وأنها التي عنى رسول الله صلى الله عليه و سلم بتفسير الآية
وذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : [ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا عائشة { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا } من هم ؟ ـ قلت : الله ورسوله أعلم قال : هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة ] الحديث الذي تقدم ذكره
قال : فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبها ودليل ذلك قوله تعالى : { واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا } فإذا اختلفوا وتعاطوا ذلك كان لحدث أحدثوه من اتباع الهوى
هذا ما قاله وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين وهذه الخاصية قد دل عليها الحديث المتكلم عليه وهي موجودة في كل فرقة من الفرق المتضمنة في الحديث
ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه و سلم في قوله : [ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ] : وأي فرقة توازي هذه الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر ؟ وهي موجودة في سائر من عرف من الفرق أو ادعي ذلك فيهم إلا أن الفرقة لا تعتبر على أي وجه كانت لأنها تختلف بالقوة والضعيف
وحيث ثبت أن مخالفة هذه الفرق من الفروع الجزئية باب الفرقة فلا بد يجب النظر في هذا كله
الخاصية الثانية هي التي نبه عليها قوله تعالى : فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية
هي التي نبه عليها قوله تعالة : { فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه } الآية فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن وجعلوا ممن شأنه أن يتبع المتشابه لا المحكم ومعنى المتشابه : ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه سواء كان من المتشابه الحقيقي ـ كالمجمل من الألفاظ وما يظهر من التشبيه ـ أو من المتشابه الإضافي وهو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله : { إن الحكم إلا لله } فإنظاهر الآية صحيح على الجملة وأما على التفصيل فمحتاج إلى البيان وهو ما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله عنهما لأنه بين أن الحكم لله تارة بغير تحكيم لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حكم الله
وكذلك قولهم : قاتل ولم يسب فإنهم حصروا التحكيم في القسمين وتركوا قسما ثالثا وهو الذي نبه قوله تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي } الآية فهذا قتال من غير سبي لكن ابن عباس نبههم على وجه أظهر وهو أن السباء إذا حصل فلا بد من وقوع بعض المقاتلين على أم المؤمنين وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في الانتفاع بها كالسبايا فيخالفون القرآن الذي ادعوا التمسك به
وكذلك في محو الإسم من إمارة المؤمنين اقتضى عندهم أنه إثبات لإمارة الكافرين وذلك غير صحيح لأن نفي الإسم منها لا يقتضي نفي المسمى
وأيضا : فإن فرضنا أنه يقتضي نفي المسمى لم يقتض إثبات إمارة أخرى فعارضهم ابن عباس بمحو النبي صلى الله عليه و سلم إسم الرسالة من الصحيفة معارضة لا قبل لهم بها ولذلك رجع منهم ألفان ـ أو من رجع منهم ـ
فتأملوا وجه اتباع المتشابهات وكيف أدى إلى الضلال والخروج عن الجماعة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
[ فإذا رأيتم الذي يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ]
الخاصية الثالثة إتباع الهوى
إتباع الهوى الذي نبه عليه قوله تعالى : { فأما الذين في قلوبهم زيغ } والزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى وكذلك قوله تعالى : { ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله } وقوله : { أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم }وليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية ولا على التي قبلها إلا ان هذه الخاصية راجعة في المعرفة بها إلى كل أحد في خاصة نفسه لأن اتباع الهوى أمر باطني فلا يعرفه غير صاحبه إذا لم يغالط نفسه إلا أن يكون عليها دليل خارجي
وقد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله :
[ اتخذ الناس رؤساء جهالا ] فكل أحد عالم بنفسه هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا ؟ وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه : هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم ؟ أم هو على شك فيه ؟ والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى إذ كان ينبغي له أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل وكل من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل هذا
قال العقلاء : رأي المستشار أنفع لأنه بريء من الهوى بخلاف من لم يستشر فإنه غير بريء ولا سيما في الدخول في المناصب العلية والرتب الشرعية كرتب العلم
فهذا أنموذج ينبه صاحب الهوى في هواه ويضبطه إلى أصل يعرف به هل هو في تصدره إلى فتوى الناس متبع للهوى أم هو متبع للشرع ؟
الخاصية الثانية فراجعة إلى العلماء الراسخين في العلم
وأما الخاصية الثانية فراجعة إلى العلماء الراسخين في العلم لأن معرفة المحكم والمتشابه راجع إليهم يعرفونها ويعرفون أهلها فهم المرجوع إليهم في بيان من هم متبع للمحكم فيقلد في الدين ومن هو المتبع للمتشابه فلا يقلد أصلاولكن له علامة ظاهرة أيضا نبه عليها الحديث الذي فسرت الآية به قال فيه :
فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم خرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق وقد تقدم أول الكتاب فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه يجادل فيه ويقيم النزاع على الإيمان وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في ريب وشك إذ المتشابه لا يعطى بيانا شافيا ولا يقف منه متبعه على حقيقة فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك به والنظر فيه لا يتخلص له فهو على شك أبدا وبذلك يفارق الراسخ في العلم لأن جداله إن افتقر إليه فهو في مواقع الإشكال العارض طلبا لإزالته فسرعان ما يزول إذا بين له موضع النظر
وأما ذو الزيغ فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه فلا يزال في جدال عليه وطلب لتأويله
ويدل على ذلك أن الآية نزلت في شأن نصارى نجران وقصدهم أن يناظروا رسول الله صلى الله عليه و سلم في عيسى ابن مريم عليهما السلام وأنه الله أو أنه ثالث ثلاثة مستدلين بأمور متشابهات من قوله : فعلنا وخلقنا وهذا كلام جماعة ومن أنه يبرىء الأكمة والأبرص ويحيي الموتى وهو كلام طائفة أخرى ولم ينظروا إلى أصله ونشأته بعد أن لم يكن وكونه كسائر بني آدم يأكل ويشرب وتلحقه الآفات والأمراض والخبر مذكور في السير
والحاصل : انهم إنما أتوا لمناظرة رسول الله صلى الله عليه و سلم ومجادلته لا يقصدون اتباع الحق
والجدال على هذا الوجه لا ينقطع ولذلك لما بين لهم الحق ولم يرجعوا عنه دعوا إلى أمر آخر خافوا منه الهلكة فكفوا عنه وهو المباهلة وهو قوله تعالى : { فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم } الآية وشأن هذا الجدال أنه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد والشطرنج وغيرهما
وقد نقل عن حماد بن زيد أنه قال : جلس عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبة ليلة يتخاصمون إلى طلوع الفجر
قال : فلما صلوا جعل عمرو يقول : هيه أبا معمر ! هيه أبا معمر ! فإذا رأيتم أحدا شأنه أبدا الجدال في المسائل مع كل أحد من أهل العلم ثم لا يرجع ولا يرعوي فاعلموا أنه زيغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه
وأما ما يرجع للأول فعامة لجميع العقلاء من الإسلام
وأما ما يرجع للأول فعامة لجميع العقلاء من الإسلام لأن التواصل والتقاطع معروف عند الناس كلهم وبمعرفته يعرف أهله وهو الذي نبه عليه حديث الفرق إذ أشار إلى الافتراق شيعا بقوله :[ وستفترق هذه الأمة على كذا ] ولكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة وأما قبل ذلك فلا يعرفه كل أحد فله علامات تتضمن الدلالة على التفرق أولها : مفاتحة الكلام وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين ممن اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف بهم ويختص بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ مخالف لهم وما أشبه ذلك
وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج ـ لعنهم الله ـ الصحابة الكرام رضي الله عنهم فإنهم ذموا من مدحه الله ورسوله واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه كعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه وصوبوا قتله إياه وقالوا : إن في شأنه نزل قوله تعالى : { ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله } وأما التي قبلها وهي قوله : { ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا } فإنها نزلت في شأن علي رضي الله عنه وكذبوا ـ قاتلهم الله ـ وقال عمران بن حطان في مدحه لابن ملجم
( يا ضربة من تقي ما أراد بها ... إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا )
( إني لأذكره يوما فأحسبه ... أوفي البرية عند الله ميزانا )
وكذب ـ لعنه الله ـ فإذا رأيت من يجري على هذا الطريق فهو من الفرق المخالفة وبالله التوفيق
وروي عن إسماعيل بن علية قال : حدثني اليسع قال : تكلم واصل بن عطاء يوما ـ يعني المعتزلي ـ فقال عمرو بن عبيد : ألا تسمعون ؟ ما كلام الحسن و ابن سيرين ـ عندما تسمعون ـ إلا خرقة حيض ملقاة
روي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفقه فكان يقول : إن علم الشافعي و أبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة
هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله
والعلامة التفصيلية
وأما العلامة التفصيلية في كل فرقة فقد نبه عليها و أشير إلى جملة منها في الكتاب والسنة وفي ظني أن من تأملها في كتاب الله وجدها منبها عليها ومشارا إليها ولولا أنا فهمنا من الشرع الستر عليها لكان في الكلام في تعيينها مجال متسع مدلول عليه بالدليل الشرعي وقد كنا هممنا بذلك في ماضي الزمان فغلبنا عليه ما دلنا على أن الأولى خلاف ذلكفأنت ترى أن الحديث الذي تعرضنا لشرحه لم يعين في الرواية الصحيحة واحدة منها لهذا المعنى المذكور والله أعلم ـ وإنما نبه عليه في الجملة لتحذر مظانها وعين في الحديث المحتاج إليه منها وهي الفرقة الناجية ليتحراها المكلف وسكت عن ذلك في الرواية الصحيحة لأن ذكرها في الجملة يفيد الأمة الخوف من الوقوع فيها وذكر في الرواية الأخرى فرقة من الفرق الهالكة لأنها ـ كما قال ـ أشد الفرق على الأمة وبيان كونها أشد فتنة من غيرها سيأتي آخرا إن شاء الله
المسألة التاسعة التوفيق بين روايات حديث الفرق
إن الرواية الصحيحة في الحديث أن افتراق اليهود كافتراق النصارى على إحدى وسبعين وهي رواية ابي داود على الشك ! إحدى وسبعين ؟ أو ثنتين وسبعين ؟ وأثبت في الترمذيفي الرواية الغريبة لبني إسرائيل الثنتين والسبعين لأنه لم يذكر في الحديث افتراق النصارى وذلك ـ والله أعلم ـ لأجل أنه إنما أجرى في الحديث ذكر بني إسرائيل فقط لأنه ذكر فيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : [ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمة علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي ] الحديث وفي أبي داود اليهود والنصارى معا إثبات الثنتين والسبعين من غير شك
وخرج الطبري وغيره الحديث على أن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين ملة وافترقت هذه الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة
فإن بنينا على إثبات إحدى الروايتين فلا إشكال لكن في رواية الإحدى والسبعين تزيد هذه الأمة فرقتين وعلى رواية الاثنتين والسبعين تزيد فرقة واحدة وثبت في بعض كتب الكلام في نقل الحديث أن اليهود افترقت على إحدى وسبعين وأن النصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقة ووافقت سائر الروايات في افتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ولم أر هذه الرواية هكذا فيما رأيته من كتب الحديث إلا ما قوع في جامع ابن وهب من حديث علي رضي الله عنه ـ وسيأتي
وإن ينينا على إعمال الروايات فيمكن أن تكون رواية الإحدى والسبعين وقت أعلم بذلك ثم أعلم بزيادة فرقة أما أنها كانت فيهم ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه و سلم في وقت آخر وإما أن تكون جملة الفرق في الملتين ذلك المقدار فأخبر به ثم حدثت الثانية والسبعون فيهما فأخبر ذلك عليه الصلاة و السلام وعلى الجملة فيمكن أن يكون الاختلاف بحسب التعريف بها أو الحدوث والله أعلم بحقيقة الأمر
المسألة العاشرة الفرقة الناجية في هذه الأمة وفي غيرها
هذه الأمة ظهر أن فيها فرقة زائدة على الفرق الأخرى اليهود والنصارى فالثنتان والسبعون من الهالكين المتوعدين بالنار والواحدة في الجنة فإذا انقسمت هذه الأمة بحسب هذا الافتراق قسمين : قسم في النار وقسم في الجنة ولم يبين ذلك في فرق اليهود ولا في فرق النصارى إذ لم يبين الحديث أن لا تقسيم لهذه الأمة فيبقى النظر : هل في اليهود والنصارى فرقة ناجية أم لا ؟ وينبني على ذلك نظران : هل زادت هذه الأمة فرقة هالكة : أم لا ؟ وهذا النظر وإن كان لا ينبني عليه لكنه من تمام الكلام في الحديثفظاهر النقل في مواضع من الشريعة أن كل طائفة من اليهود والنصارى لا بد أن يوجد فيها من آمن بكتابه وعمل بسنته كقوله تعالى : { ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون } ففيه إشارة إلى أن منهم من لم يفسق وقال تعالى : { فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون } وقال تعالى : { ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون } وقال تعالى : { منهم أمة مقتصدة } وهذا كالنص
وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
[ أيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران ] فهذا يدل بإشارته على العمل بما جاء به نبيه وخرج عبد الله بن عمر [ عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا عبد الله بن مسعود : ـ قلت : لبيك رسول الله قال ـ أتدري أي عرى الإيمان أوثق ؟ ـ قال ـ قلت : الله ورسوله أعلم قال : الولاية في الله والحب في الله والبغض فيه ـ ثم قال : يا عبد الله بن مسعود ! ـ قلت : لبيك رسول الله ! ثلاث مرات قال ـ أتدري أي الناس أفضل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال ـ فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم ـ ثم قال ـ يا عبد الله بن مسعود ! ـ قلت لبيك يا رسول الله ! ثلاث مرات قال ـ هل تدري أي الناس أعلم ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : أعلم الناس أبصرهم للحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على استه واختلف من قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث وهلك سائرها فرقة آذت الملوك وقاتلتهم على دين عيسى ابن مريم حتى قتلوا وفرقة لم يكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فأخذتهم الملوك وقطعتهم بالمناشير وفرقة لم يكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فساحوا في الجبال وهربوا فيها فهم الذين قال الله عز و جل فيهم : { ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون } ] فالمؤمنون الذين آمنوا بي وصدقوا بي والفاسقون الذين كذبوا بي وجحدوا بي فأخبر أن فرقا ثلاثا نجت من تلك الفرق المعدودة والباقية هلكت
وخرج ابن وهب من حديث علي رضي الله عنه أنه دعا رأس الجالوت وأسقف النصارى فقال : إني سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منكما فلا تكتما يا رأس جالوت ! أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى وأطعمكم المن والسلوى وضرب لكم في البحر طريقا يبسا وجعل لكم الحجر الطوري يخرج لكم منه اثنتي عشرة عينا لكل سبط من بني إسرائيل عين ! إلا ما أخبرتني على كم افترقت اليهود من فرقة بعد موسى ؟ فقال له : ولا فرقة واحدة فقال له علي : كذبت والذي لا إله إلا هو لقد افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة
ثم دعا الأسقف فقال : انشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعل على رجله البركة واراكم العبرة فأبرأ الأكمة والأبرص وأحيا الموتى وصنع لكم من الطين طيورا وأنبأكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم فقال : دون هذا الصدق يا أمير المؤمنين فقال له علي رضي الله عنه كم افترقت النصارى بعد عيسى ابن مريم من فرقة ؟ قال : لا والله ولا فرقة فقال ثلاث مرات : كذبت والله الذي لا إله إلا الله لقد افترقت على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فقال : أما أنت يا يهودي ! فإن الله يقول : { ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون } فهي التي تنجو وأما نحن فيقول الله فينا : { وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون } فهذه التي تنجو من هذه الأمة ففي هذا أيضا دليل
وخرجه الآجري أيضا من طريق أنس بمعنى حديث علي رضي الله عنه : إن واحدة من فرق اليهود ومن فرق النصارى في الجنة
وخرج سعيد بن منصور في تفسيره من حديث عبد الله : أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم وكان الحق يحول بين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فقالوا : اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم قالوا : لا ! بل أرسلوا إلى فلان ـ رجل من علمائهم ـ فاعرضوا عليه هذا الكتاب فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا : أتؤمن بهذا ؟ فأومأ إلى صدره فقال : آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا ؟ ( يعني الكتاب الذي في القرن ) فخلوا سبيله وكان له أصحاب يغشونه فلما مات نبشوه فوجدوا القرن ووجدوا الكتاب فقالوا : ألا ترون قوله : آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا ؟ وإنما عنى هذا الكتاب فاختلف بنو إسرائيل على بضع وسبعين ملة وخير مللهم أصحاب ذلك القرن ـ قال عبد الله ـ : وإن من بقي منكم سيرى منكرا بحسب أمره يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره إن يعلم الله من قلبه خيرا كاره
فهذا الخبر يدل على أن في بني إسرائيل فرقة كانت على الحق الصريح في زمانهم لكن لا أضمن عهدة صحته ولا صحة ما قبله
وإذا ثبت أن في اليهود والنصارى فرقة ناجية لزم من ذلك أن يكون في هذه الأمة فرقة ناجية زائدة على رواية الثنتين والسبعين أو فرقتين بناء على رواية الإحدى والسبعين فيكون لها نوع من التفرق لم يكن لمن تقدم من أهل الكتاب لأن الحديث المتقدم أثبت أن هذه الأمة تبعث من قبلها من أهل الكتابين في أعيان مخالفتها فثبت أنها تبعتها في أمثال بدعتها وهذه هي :