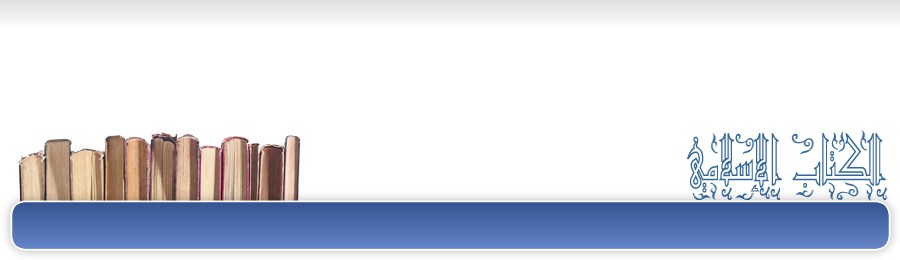كتاب : طريق الهجرتين وباب السعادتين
المؤلف : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية
بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أعماله وأحواله وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله فإن الرب إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إليه ثم أعرض عنها أو وجد بارقة من حبه ثم سلبها لم ينفذ إلى ربه منها خصوصا اذا مال بتلك الإرادة إلى شيء من اللذات وانصرف بجملته إلى تحصيل الأغراض والشهوات عاكفا على ذلك في ليله ونهاره وغدوه ورواحه هابطا من الأوج الأعلى إلى الحضيض الأدنى قد مضت عليه برهة من أوقاته وكان همه الله وبغيته قربه ورضاه وإيثاره على كل ما سواه على ذلك يصبح ويمسي ويظل ويضحي وكان الله في تلك الحال وليه لأنه ولي من تولاه وحبيب من أحبه ووالاه فأصبح في سجن الهوى ثاويا وفي أسر العدو مقيما وفي بئر المعصية ساقطا وفي أودية الحيرة والتفرقة هائما معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية كان قلبه يحوم حول العرش فأصبح محبوسا في أسفل الحش
فأصبح كالبازي المنتف ريشه ... يرى حسرات كلما طار طائر
وقد كان دهرا في الرياض منعما ... على كل ما يهوى من الصيد قادر
إلى أن أصابته من الدهر نكبة ... إذا هو مقصوص الجناحين حاسر
فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها يا عجبا له بأي شيء تعوض وكيف قر قراره فما طلب الرجوع إلى أحنيته وما تعرض وكيف اتخذ سوى أحنيته سكنا وجعل قلبه لمن عاداه مولاه من أجله وطنا أم كيف طاوعه قلبه على الاصطبار ووافقه على مساكنة الأغيار فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم ويا مسخطا من حياته وراحته وفوزه في
رضاه وطالبا رضى من سعادته في إرضاء سواه إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها فرح ساعة لا شهر وغم سنة بل دهر طعام لذيذ مسموم أوله لذة وآخره هلاك فالعامل عليها والساعي في تحصيلها كدودة القز يسد على نفسه المذاهب بما نسج عليها من المعاطب فيندم حين لا تنفع الندامة ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة لأنهم تبع لمولاهم فإذا أحب عبدا أحبوه وإذا والى واليا والوه إذا أحب الله العبد نادى يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه فينادي جبرائيل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض فيوضع له القبول بينهم ويجعل الله قلوب أوليائه تفد إليه بالود والمحبة والرحمة وناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته ويقبل عليه بأنواع كرامته ويلحظه الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
قاعدة السائر إلى الله والدار الآخرة بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين قوة علمية وقوة عملية فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب
أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها فيكشف له النور عن الأمرين أعلام الطريق ومعاطبها وبالقوة العملية يسير حقيقة بل السير هو حقيقة القوة العملية فإن السير هو عمل المسافر وكذلك السائر إلى ربه إذا ابصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة والفلاح وبقي عليه الشطر الآخر وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة فهو يقول يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الأحبة فإن صبرت وواصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلة وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة وعمرك درجة من درج تلك الساعة فالله الله لا تنقطعي في المفازة فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديهم من الإكرام والإنعام وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة فلتختر أيها شاءت وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها
وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها ولا يوحشه انفراده في طريق سفره ولا يغتر بكثرة المنقطعين فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم بل هي من عوارض الطريق فسوف تبدو له الخيام وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول إليهم فيا قرة عينه إذ ذاك ويا فرحته إذ يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء سيرها فكلما أدمن على السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث والأدران فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم فتبدلت وحشته أنسا وكثافته لطافة ودرنه طهارة
فصل في تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعملية
فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه ويكون ضعيفا في القوة العملية يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها فهو فقيه ما لم يحضر العمل وإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات فداء هذا من جهله وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم بل على طريق الذوق والوجد والعادة يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبده فتارة يعبده بذوقه ووجده وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه من لبس معين أو كشف رأس أو حلق لحية ونحوها وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلقين وليس له أصل في الدين وتارة يعبده بما تحبه نفسه وتهواه كائنا ما كان وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن شريعته ودينه لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد دينا سواه كما أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرف بها إلى عباده على ألسنة رسله ودعاهم إلى معرفته ومحبته من طريقها فلا معرفة بالرب ولا عبادة له ومن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته فإن القواطع كثيرة شأنها شديد لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين ولو شاء الله لأزالها وذهب بها ولكن الله يفعل ما يريد والوقت كا قيل سيف فإن قطعته وإلا قطعك فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع والله ولي التوفيق
قاعدة نافعة العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه ومدة سفره هي عمره الذي كتب له فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل سفره فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه فيهتم بقطعها سالما غانما فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه ويمتد أمله ويحصر بالتسويف والوعد والتأخير والمطل بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل فطوعت له نفسه الانقياد إلى التزويد فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته فإذا طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد سراه وينجاب عنه كراه فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه
ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان فقسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاء فكلما قطعوا منها مرحلة قربوا من تلك الدار وبعدوا عن ربهم وعن دار كرامته فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب ومعاداة رسله وأوليائه ودينه والسعي في إطفاء نوره وإبطال دعوته وإقامة دعوة غيرها فهؤلاء جعلت أيامهم يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لها واستعملوا بها فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم يسوقهم إلى منازلهم سوقا كما قال تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي تزعجهم إلى المعاصي والكفر إزعاجا وتسوقهم سوقا القسم الثاني قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام وهم ثلاثة أقسام ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله وهؤلاء كلهم مستعدون للسير موقنون بالرجعى إلى الله ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره وفي نفس السير وسرعته وبطئه فالظالم لنفسه مقصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في طريقه ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة الرابحة ولم يتزود ما يضره فهو سالم غانم لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع المكاسب الفاخرة والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات لعلمه بمقدار المربح الحاصل فيرى خسرانا أن يدخر شيئا مما بيده ولا يتجر به فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجاراتهم فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة الدرهم يكسب فيها عشرة إلى سبعمائة وأكثر وعنده حاصل وله خبرة بطريق ذلك البلد وخبرة بالتجارة فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيء به تجارة إلى ذلك البلد لفعل
فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن الله يرى خسرانا بينا أن يمر عليه وقت في غير متجر فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم العبد من أي التجار هو
فأما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه فحركت جوارحه طالبة لها فإذا زاحمها حقوق ربه فتارة وتارة فمرة يأخذ بالرخصة ومرة بالعزيمة ومرة يقدم على الذنب وترك الحق تهاونا ووعدا بالتوبة فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والتصديق بالثواب والعقاب فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران وهو للأغلب منهما فإذا ورد القيامة ميز ربحه من خسرانه وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده وكان الحكم للراجح منهما وحكم الله من وراء ذلك لا يعدم منه فضله وعدله
وأما المقتصدون فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولا نقصوا منها فلا حصلوا على أرباح التجار ولا بخسوا الحق الذي عليهم فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في وقتها بأركانها وواجباتها وشرائطها ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله فيها مشتغلا بها قائما بأعيانها مؤديا واجب الرب فيها غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد الأذكار والتوجه فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها فإذا أكملها انصرف إلى حاله الأول فهو كذلك سائر يومه فإذا جاء الليل إلى حين النوم يأخذ الواجب ويقوم بحقه وكذلك الزكاة الواجبة والحج الواجب وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط لا يظلمهم ولا يترك حقه لهم
وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان أبرار ومقربون وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين وهم المقتصدون والأبرار والمقربون وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق وإن كان مآله إلى مصير
المؤمنين بعد أخذ الحق منه وقد اختلف في قوله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب الآية هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات أو يختص بالقسمين الأخيرين وهما المقتصد والسابق دون الظالم على قولين فذهبت طائفة إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة وهذا يروى عن ابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين قال أبو إسحق السبيعي أما الذي سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج قال أبو داود الطائي أنبأنا الصلت بن دينار حدثنا عقبة بن صهبان الهنائي قال سألت عائشة عن قول الله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فقالت لي يا بني كل هؤلاء في الجنة فأما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله يشهد له رسول الله بالخيرة والرزق وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك قال فجعلت نفسها معنا
وقال ابن مسعود هذه الأمة يوم القيامة أثلاث ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يوم القيامة يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة
وثلث يجيئون بذنوب عظام فيقول الله ما هؤلاء وهو أعلم بهم فتقول الملائكة هم مذنبون إلا أنهم لم يشركوا فيقول الله أدخلوهم في سعة رحمتي
وقال كعب تحاذت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم
وقال الحسن السابقون من رجحت حسناتهم والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته والظالم من خفت موازينه واحتجت هذه الفرقة بأنه سبحانه سمى الكل مصطفين وأخبر أنه اصطفاهم من جملة العباد ومحال أن يكون الكافر والمشرك من المصطفين لأن الاصطفاء هو الاختيار وهو الافتعال من صفوة الشيء وهو خياره فعلم أن هؤلاء الأصناف الثلاثة صفوة الخلق وبعضهم خير من بعض فسابقهم مصطفى عليهم ثم مقتصدهم مصطفى على ظالمهم ثم ظالمهم مصطفى على الكافر والمشرك واحتجت أيضا بآثار روتها تؤيد ما ذهبت إليه فمنها ما رواه سليمان الشاذكوني حدثنا حصين بن بهر عن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أسامة بن زيد عن النبي في هذه الآية قال كلهم في الجنة
ومنها ما رواه الطبراني حدثنا أحمد بن حماد بن رعية حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن أحمد بن حازم المعارفي عن صالح مولى التوأمة عن أبي الدرداء قال قرأ النبي هذه الآية فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فقال أما السابق فيدخل الجنة
بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا وأما الظالم فيجلس في طول المحبس ثم يتجاوز الله عنه
ومنها ما رواه زكريا الساجي بن سالم عن سعد بن طريف عن أبي هاشم الطائي قال قدمت المدينة فدخلت مسجدها فجلست إلى سارية فجاء حذيفة فقال ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله يقول يبعث الله تبارك وتعالى هذه الأمة أو كما قال ثلاثة أصناف وذلك في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فالسابق بالخيرات يدخل الجنة بلا حساب والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا والظالم لنفسه يدخل الجنة برحمة الله
ومنها ما رواه الطبراني عن محمد بن إسحق بن راهويه حدثنا أبي حدثنا جرير عن الأعمش عن رجل سماه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله يقول في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه الآية قال السابق بالخيرات والمقتصد يدخلان الجنة بغير حساب والظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة
ومنها ما رواه ابن لهيعة عن أبي جعفر عن يونس بن عبدالرحمن عن
أبي الدرداء قال سمعت رسول الله يقول هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى قول الله سابق بالخيرات قال فأما السابقون فيدخلون الجنة بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا وأما الظالمون فيحاسبون فيصيبهم عناء وكرب ثم يدخلون الجنة ثم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ومنها ما رواه الحميدي حدثنا سفيان حدثنا طعمة بن عمرو الجعفري عن رجل قال قال أبو الدرداء لرجل ألا أحدثك بحديث أخصك به لم أحدث به أحدا قال رسول الله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد جنات عدن قال دخلوا الجنة جميعا واحتجت أيضا بالآيات والأحاديث التي تشهد بنجاة الموحدين من أهل الكبائر ودخولهم الجنة واحتجت أيضا بأن ظلم النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي فإن الظلم ثلاثة أنواع ظلم في حق النفس باتباعها شهواتها وإيثارها لها على طاعة ربها وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم وظلم في حق الرب بالشرك به فظلم النفس إنما هو بالمعاصي وقد تواترت النصوص بأن العصاة من الموحدين مآلهم إلى الجنة
وقالت طائفة بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون الظالم لنفسه فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق والظالم لنفسه هنا هو الكافر والمقتصد المؤمن العاصي والسابق المؤمن التقي وهكذا يروى عن عكرمة والحسن وقتادة وهو اختيار جماعة من المفسرين منهم صاحب الكشاف ومنذر بن سعيد في تفسيره والرماني وغيرهم قالوا وهذه الآية متناولة لجميع أقسام الخلق شقيهم وسعيدهم وهي نظير آية وكنتم
أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون قالوا فأصحاب الميمنة هم المقتصدون وأصحاب المشأمة الظالمون لأنفسهم والسابقون السابقون هم السابقون بالخيرات قالوا ولم يصطف الله من خلقه ظالما لنفسه بل المصطفون من عباده هم صفوته وخيارهم والظالمون لأنفسهم ليسوا خيار العباد بل شرارهم فكيف يوقع عليهم اسم المصطفين ويتناولهم فعل الاصطفاء قالوا وأيضا صفوة الله هم أحباؤه والله لا يحب الظالمين فلا يكونون مصطفين قالوا ولأن الظالم لنفسه وإن كان ممن أورث الكتاب فهو بتركه العمل بما فيه قد ظلم نفسه والله سبحانه إنما اصطفى من عباده من أورثه كتابه ليعمل بما فيه فأما من نبذه وراء ظهره فليس من المصطفين من عباده قالوا ولأن الاصطفاء افتعال من صفوة الشيء وهو خلاصته ولبه وأصله اصتفى فأبدلت التاء طاء لوقوعها بعد الصاد كالاصطباح والاصطلام ونحوه والظالم لنفسه ليس صفوة العباد ولا خلاصتهم ولا لبهم فلا يكون مصطفى قالوا ولأن الله سلم على المصطفين من عباده فقال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وهذا يقتضي سلامتهم من كل شر وكل عذاب والظالم لنفسه غير سالم من هذا ولا هذا فكيف يكون من المصطفين قالوا وأيضا فطريقة القرآن أن الوعد المطلق بالثواب إنما يكون للمتقين لا للظالمين كقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فأين الظالم لنفسه هنا وقوله تعالى أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين وقوله إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا والقرآن مملوء من هذا ولم يجئ فيه موضع واحد بإطلاق الوعد بالثواب للظالم لنفسه أصلا قالوا وأيضا فلم يجئ في القرآن ذكر الظالم لنفسه إلا في معرض الوعيد لا الوعد كقوله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقوله فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق وقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قالوا وأيضا فالظالم لنفسه هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته والقرآن كله يدل على خسارته وأنه غير ناج كقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وقوله وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فكيف يذكر وعده بجناته وكرامته للظالمين أنفسهم الخفيفة موازينهم قالوا وأيضا فقوله تعالى جنات عدن مرفوع لأنه بدل من قوله ذلك هو الفضل الكبير وهو بدل نكرة من معرفة كقوله لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة وحسن وقوعه مجيء النكرة موصوفة لتخصيصها بالوصف وقربها من المعرفة ومعلوم أن المبدل منه وهو الفضل الكبير مختص بالسابقين بالخيرات والمعنى أن سبقهم
بالخيرات بإذنه ذلك هو الفضل الكبير وهو جنات عدن يدخلونها وجعل السبق بالخيرات نفس الجنات لأنه سببها وموجبها قالوا وأيضا فإنه وصف حليتهم فيها بأنها أساور من ذهب ولؤلؤ وهذه جنات السابقين لا جنات المقتصدين فإن جنات الفردوس أربع كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ومعلوم أن الجنتين الذهبيتين أعلى وأفضل من الفضيتين فإذا كانت الجنتان الذهبيتان للظالمين لأنفسهم فمن يسكن الجنتين الفضيتين فعلم أن هذه الجنات المذكورة لا تتناول الظالمين لأنفسهم قالوا وأيضا فإن أقرب المذكورات إلى ضمير الداخلين هم السابقون بالخيرات فوجب اختصاصهم بالدخول إلى الجنات المذكورات قالوا وفي اختصاصهم بعد ذكر الأقسام بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما هو معلوم من طريقة القرآن إذ يصرح بذكر ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين ومن رجحت حسناتهم ويذكر عقاب الكفار والفجار والظالمين لأنفسهم ومن خفت موازينهم ويسكت عن القسم الذي فيه شائبتان وله مادتان هذه طريقة القرآن كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقوله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وهذا كثير في القرآن قالوا وفي السكوت عن شأن صاحب الشائبتين تحذير
عظيم وتخويف له بأن أمره مرجأ إلى الله وليس عليه ضمان ولا له عنده وعد ليحذر كل الحذر وليبادر بالتوبة النصوح التي تلحقه بالمضمون لهم النجاة والفلاح قالوا وأيضا فمن المحال أن يقع على أحد من المصطفين اسم الظلم مطلقا وإنما يقع اسم الظلم على الكافر كما قال تعالى يا أيها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير مع قوله الله ولي الذين امنوا والظالم لا ولي له فلا يكون من المؤمنين قالوا وأيضا فمن تدبر الآيات وتأمل سياقها وجدها قد استوعبت جميع أقسام الخلق ودلت على مراتبهم في الجزاء فذكر سبحانه أن الناس نوعان ظالم محسن ثم قسم المحسن إلى قسمين مقتصد وسابق ثم ذكر جزاء المحسن فلما فرغ منه ذكر جزاء الظالم فقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين فذكر أنواع العباد زجزاءهم قالوا وأيضا فهذه طريقة القرآن في ذكر أصناف الخلق الثلاثة كما ذكرهم الله تعالى في سورة الواقعة والمطففين وسورة الإنسان فأما سورة الواقعة فذكرهم في أولها وفي آخرها فقال في أولها وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمةما أصحاب المشأمة
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فأصحاب المشأمة هم الظالمون وأما أصحاب اليمين فقسمان أبرار وهم أصحاب الميمنة وسابقون وهو المقربون وفي آخرها فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنت نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فذكر حالهم في القيامة الكبرى في أول السورة ثم ذكر حالهم في القيامة الصغرى في البرزخ في آخر السورة ولهذا قدم قبله ذكر الموت ومفارقة الروح فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعوهنها إن كنتم صادقين ثم قال فأما إن كان من المقربين إلى آخرها وأما في أولها فذكر أقسام الخلق عقب قوله إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فهؤلاء الظالمون أصحاب المشأمة ثم قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا فهؤلاء الظالمون أصحاب المشأمة ثم قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا فهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين ثم قال
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا فهؤلاء المقربون السابقون ولهذا خصهم بالإضافة إليه وأخبر أنهم يشربون بتلك العين صرفا محضا وأنها تمزج للأبرار مزجا كما قال في سورةالمطففين في شراب الأبرار ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وقال يشرب بها المقربون ولم يقل منها إشعارا بأن شربهم بالعين نفسها خالصة لا بها وبغيرها فضمن يشرب معنى يروى فعدى بالباء وهذا ألطف مأخذا وأحسن معنى من أن يجعل الباء بمعنى من ويضمن يشرب الفعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته وهذه طريقة الحذاق من النحاة وهي طريقة سيبويه وأئمة أصحابه وقال في الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا لأن شرب المقربين لما كان أكمل استعير له الباء الدالة على شرب الري بالعين خالصة ودلالة القرآن ألطف وأبلغ من أن يحيط بها البشر وقال تعالى في سورة المطففين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم إلى قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون فهؤلاء الأبرار المقتصدون وأخبر أن المقربين يشهدون كتابهم أي يكتب بحضرتهم ومشهدهم لا يغيبون عنه اعتناء به وإظهارا لكرامة صاحبه ومنزلته عند ربه ثم ذكر سبحانه نعيم الأبرار ومجالستهم ونظرهم إلى ربهم وظهور نضرة النعيم في وجوههم ثم ذكر شرابهم فقال يسقون من
رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ثم قال ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون والتسنيم أعلى أشربة الجنة فأخبر سبحانه أن مزاج شراب الأبرار من التسنيم وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج ولهذا قال عينا يشرب بها المقربون كما قال تعالى في سورة الإنسان سواء قال ابن عباس وغيره يشرب بها المقربون صرفا ويمزج لأصحاب اليمين مزجا وهذا لأن الجزاء وفاق العمل فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص شرابهم وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم فمن أخلص أخلص شرابه ومن مزج مزج شرابه
يا لاهيا في غمرة الجهل والهوى ... صريعا على فرش الردى يتقلب
تأمل هداك الله ما ثم وانتبه ... فهذا شراب القوم حقا يركب
وتركيبه في هذه الدار إن تفت ... فليس له بعد المنية مطلب
فيا عجبا من معرض عن حياته ... وعن حظه العالي ويلهو ويلعب
ولو علم المحروم أي بضاعة ... أضاع لأمسى قلبه يتلهب
فإن كان لا يدري فتلك مصيبة ... وإن كان يدري فالمصيبة أصعب
بلى سوف يدري حين ينكشف الغطا ... ويصبح مسلوبا ينوح ويندب
ويعجب ممن باع شيئا بدون ما ... يساوي بلا علم وأمرك أعجب
لأنك قد بعت الحياة وطيبها ... بلذة حلم عن قليل سيذهب
فهلا عكست الأمر إن كنت حازما ... ولكن أضعت الحزم والحكم يغلب
تصد وتنأى عن حبيبك دائما ... فأين عن الأحباب ويحك تذهب
ستعلم يوم الحشر أي تجارة ... أضعت إذا تلك الموازين تنصب
قالوا فهكذا هذه الآيات التي في سورة الملائكة ذكر فيها الأقسام الثلاثة الظالم لنفسه وهو من أصحاب الشمال وذكر المقتصد وهو من أصحاب اليمين وذكر السابقين وهم المقربون قالوا وليس في الآية ما يدل على اختصاص الكتاب بالقرآن والمصطفين بهذه الأمة بل الكتاب اسم جنس للكتب التي أنزلها على رسله فإنه أورثها المصطفى من عباده من كل أمة والأنبياء هم الذين أورثوه أولا ثم أورثوه المصطفين من أممهم بعدهم قال تعالى ولقد اتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فأخبر أنه إنما يكون هدى وذكرى لمن له لب عقل به الكتاب وعمل بما فيه والعامل بما فيه هو الذي أورثه الله علمه وتأمل قوله تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب كيف حذف الفاعل هنا وبنى الفعل للمفعول لما كان في معرض الذم لهم ونفى العلم عنهم ولما كان في سياق ذكر نعمه وآلائه ومنته عليهم قال وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ونظير هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومن ذلك قوله فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه وأنه لما كان الكلام في سياق ذمهم على اتباعهم شهواتهم وإيثارهم العرض الفاني على حظهم من الآخرة وتماديهم في ذلك لم ينسب التوريث إليه بل نسبه إلى المحل فقال أورثوا الكتاب
ولم يقل أورثناهم الكتاب وقد ذكرت نظير هذا في قوله آتيناهم الكتاب أنه للمدح وأورثوا الكتاب إما في سياق الذم وإما منقسم في كتاب التحفة المكية والمقصود أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباد أولا وآخرا قالوا وقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه لا يرجع إلى المصطفين بل إما أن يكون الكلام قد تم عند قوله من عبادنا ثم استأنف جملة أخرى وذكر فيها أقسام العباد وأنهم منهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق ويكون الكلام جملتين مستقلتين بين في إحداهما أنه أورث كتابه من اصطفاه من عباده وبين في الأخرى أن من عباده ظالما ومقتصدا وسابقا وإما أن يكون المعنى تقسيم المرسل إليهم بالنسبة إلى قبول الكتاب وأن منهم من لم يقبله وهو الظالم لنفسه ومنهم من قبله مقتصدا فيه ومنهم من قبله سابقا بالخيرات بإذن الله قالوا والذي يدل على هذا الوجه أنه سبحانه ذكر إرساله في كل أمة نذيرا ممن تقدم هذه الأمة فقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ثم ذكر أن رسلهم جاءتهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير الآيات الدالة على صدقهم وصحة رسالاتهم والزبر الكتاب واحدها زبور بمعنى مزبور أي مكتوب الكتاب المنير من باب عطف الخاص على العام لتميزه علن المسمى العام بفضله وشرفه امتاز بها واختص بها عن غيره وهو كعطف جبريل وميكال على الملائكة وكعطف أولي العزم على النبيين من قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم والكتاب المنير ههنا
التوراة والإنجيل ثم ذكر إهلاك المكذبين لكتابه ورسله فقال ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ثم ذكر التالين لكتابه وهم المتبعون له العالمون بشرائعه فقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ثم ذكر الكتاب الذي يخص به خاتم أنبيائه ورسله محمدا فقال والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم ذكر من أورثهم الكتاب بعد أولئك وأنه اصطفاهم لتوريث كتابه إذ رده المكذبون ولم يقبلوا توريثه
قالوا وأما قولكم إن الاصطفاء افتعال من الصفوة وهي الخيار وهي إنما تكون في السعداء فهذا بعينه حجة لنا في أن الظلم لنفسه ليس ممن اصطفاه الله من عباده وقد تقدم تقريره قالوا وأما الآثار التي رويتموها عن النبي في ذلك فكلها ضعيفة الأسانيد ومنقطعة لا تثبت كيف وهي معارضة بآثار مثلها أو أقوى منها قال ابن مردويه في تفسيره حدثنا الحسن بن عبدالله حدثنا صالح بن أحمد حدثنا أحمد بن محمد بن المعلى الأدمي حدثنا حفص بن عمار حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه قال الكافر قالوا وأما النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يدخلون
الجنة فصحيح لا ننازعكم فيها غير أنها مطلقة ولها شروط وموانع كما أن النصوص الدالة على عذاب أهل الكبائر صحيحة متواترة ولها شروط وموانع يتوقف لحوق الوعيد عليها فكذلك نصوص الوعد يتوقف مقتضاها على شروطها وانتفاء موانعها قالوا وأما قولكم إن ظلم النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي دون الكفر فليس بصحيح فقد ذكر القرآن ما ييدل على أن ظلم النفس يكون بالكفر والشرك ولو لم يكن في هذا إلا قول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وقوله عز و جل وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ونظائره كثيرة
قالت الطائفة الأولى لو تدبرتم القرآن حق تدبره وأعطيتم الآيات حقها من الفهم وراعيتم وجوهه الدالة وسياق الكلام لعلمتم أن الصواب معنا وأن هذا التقسيم الذي دلت عليه أخص من التقسيم المذكور في سورة الواقعة والإنسان والمطففين فإن ذلك تقسيم للناس إلى شقي وسعيد وتقسيم السعداء إلى أبرار ومقربين وتلك القسمة خالية عن ذكر العاصي الظالم لنفسه وأما هذه الآيات ففيها تقسيم الأمة إلى محسن ومسيء فالمسيء هو الظالم لنفسه والمحسن نوعان مقتصد وسابق بالخيرات فإن الوجود شامل لهذا القسم بل هو أغلب أقسام الأمة فكيف يخلو القرآن عن ذكره وبيان حكمه ثم لما استوفى أقسام الأمة ذكر الخارجين عنهم وهم الذين كفروا فعمت الآية أقسام الخلق كلهم وعلى ما ذهبتم إليه تكون الآية قد أهملت ذكر القسم الأغلب الأكثر وكررت ذكر حكم الكافر
أولا وآخرا ولا ريب أن ما ذكرناه أولى لبيان هذا القسم وعموم الفائدة وأيضا فإن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صريح في أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده وقوله عز و جل فمنهم ظالم لنفسه إما أن يرجع إلى الذين اصطفاهم وإما أن يرجع غلى العباد وجوعه إلى الذين اصطفاهم لوجهين أحدهما أن قوله تعالى ومنهم مقتصد ومنهم سابق إنما يرجع إلى المصطفين لا إلى العباد فكذلك قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ولا يقال بل الضمائر كلها تعود على العباد لأن سياق الآية والإتيان بالفاء والتقسيم المذكور كله يدل على أن المراد بيان أقسام الوارثين للكتاب لا بيان أقسام العباد إذ لو أراد ذلك لأتى بلفظ يزيل الوهم ولا يلتبس به المراد بغيره وكأن وجه الكلام على هذا أن يقال ومن عبادنا ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منهم وهذا معنى الكلام عندكم ولا ريب أن سياق الآية لا يدل عليه إنما يدل على أنه أورث الكتاب طائفةمن عباده وأن تلك الطائفة ثلاث أقسام هذا وجه الكلام الذي يدل عليه ظاهره الثاني أنك إذا قلت أعطيت مالي البالغين من أولادي فمنهم تاجر ومنهم خازن ومنهم مبذر ومسرف هل يفهم من هذا أحد قط أن هذا التقسيم لجملة أولاده بل لا يفهم منه إلا أن أولاده كانوا في أخذهم المال أقساما ثلاثة ولهذا أتى فيها بالفاء الدالة على تفصيل ما أجمله أولا كما إذا قلت خذ هذا المال فأعط فلانا كذا وأعط فلانا كذا ونظائره متعددة ولا وجه للإتيان بالفاء ههنا إلا تفصيل المذكور أولا لا تفصيل المسكوت عنه والآية قد سكتت عن تفصيل العباد الذين اصطفى منهم من أورثه الكتاب فالتفصيل للمذكور ليس إلا فتأمله فإنه واضح قالوا وأما قولكم إن الله لا يصطفي من عباده ظالما لنفسه لأن الاصطفاء هو الاختيار من الشيء صفوته وخياره إلى آخر ما ذكرتم فجوابه أن كون العبد
مصطفى ووليا لله ومحبوبا لله ونحو ذلك من الأسماء الدالة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له لا ينافي ظلم العبد نفسه أحيانا بالذنوب والمعاصي بل أبلغ من ذلك أن صدقيته لا تنافي ظلمه لنفسه ولهذا قال صديق الأمة وخيارها للنبي علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وقد قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وأخبر سبحانه عن صفات المتقين وأنهم يقع منه ظلم النفس والفاحشة لكن لا يصرون على ذلك وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون فهؤلاء الصديقون المتقون قد أخبر سبحانه أن لهم أعمالا سيئة يكفرها ولا ريب أنها ظلم للنفس وقال موسى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وقال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقال تعالى إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإن غفور رحيم وإذا كان ظلم النفس لا ينافي الصديقية والولاية ولا يخرج العبد عن كونه من المتقين بل يجتمع فيه الأمران يكون وليا لله صديقا متقيا وهو مسيء ظالم لنفسه علم أن ظلمه لنفسه لا يخرجه عن كونه من الذين اصطفاهم الله من عباده وأورثهم كتابه إذ هو مصطفى من جهة كونه من ورثة الكتاب علما وعملا ظالم لنفسه من جهة تفريطه في بعض ما أمر به وتعديه بعض ما نهي عنه كما يكون الرجل وليا لله محبوبا له من جهة ومبغبوضا له من جهة أخرى وهذا عبد الله لخمار كان يكثر شرب الخمر والله يبغضه من هذه الجهة ويحب الله ورسوله ويحبه الله ويواليه من هذه الجهة ولهذا نهى النبي عن لعنته وقال إنه يحب الله ورسوله ونكتة المسألة أن الاصطفاء والولاية والصديقية وكون الرجل من الأبرار ومن المتقين ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التجزيء والانقسام والكمال ولانقصان كما هو ثابت باتفاق المسلمين في أصل الإيمان وعلى هذا فيكون هذا القسم مصطفى من وجه ظالما لنفسه من وجه آخر وظلم النفس نوعان نوع لا يبقى معه شيء من الإيمان والولاية والصديقية والاصطفاء وهو ظلمها بالشرك والكفر ونوع يبقى معه حظه من الإيمان والاصطفاء والولاية وهو ظلمها بالمعاصي وهو درجات متفاوتة في القدر والوصف فهذا التفصيل يكشف قناع المسألة
ويزيل أشكالها بحمد الله قالوا وأما قولكم إن قوله تعالى جنات عدن مرفوع لأنه بدل من قوله ذلك هو الفضل الكبير وهو مختص بالسابقين وذكر حليتهم فيها من أساور من ذهب يدل على ذلك إلخ فجوابه من وجهين أحدهما أن هذا بعينه وارد عليكم فإن المقتصد من أهل الجنات ومعلوم أن جنات السابقين بالخيرات أعلى وأفضل من جناته فما كان جوابكم عن المقتصد فهو الجواب بعينه عن الظالم لنفسه فإن التفاوت حاصل بين جنات الأصناف الثلاثة ويختص كل صنف بما يليق بهم ويقتضيه مقامهم وعلمهم الجواب الثاني أنه سبحانه ذكر جزاء السابقين بالخيرات هنا مشوقا لعباده إليه منبها لهم على مقداره وشرفه وسكت عن جزاء الظالمين لأنفسهم والمقتصدين ليحذر الظالمون ويجد المقتصدون وذكر في سورة الإنسان جزاء الأبرار منبها على ما هو أعلى وأجل منه وهو جزاء المقربين السابقين ليدل على أن هذا إذا كان جزاء للأبرار المقتصدين فما الظن بجزاء المقربين السابقين فقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى قوله ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة إلى قوله عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فذكر هنا الأساور من الفضة والأكواب من الفضة في جزاء الأبرار وذكر في سورة الملائكة الأساور من الذهب في جزاء السابقين بالخيرات فعلم جزاء المقتصدين من سورة الإنسان وعلم جزاء السابقين من سورة الملائكة فانتظمت السورتان جزاء المقربين على اتم الوجوه والله أعلم بأسرار كلامه وحكمه قالوا وهذا هو الجواب عن قولكم إن الضمير يختص به أقرب مذكور إليه قالوا وأما قولكم إن الظالم لنفسه
إنما هو الكافر فقد تقدم جوابه وذكر ما يبطله قالوا وأما قولكم إن هذه الآيات نظير آيات الواقعة وسورة الإنسان وسورة المطففين في تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام أصحاب الشمال وأصحاب اليمين والمقربون فلا ريب أن هذه الآية وافية بالأقسام الثلاثة مع مزيد تقسيم آخر وهو تقسيم أصحاب اليمين إلى ظالم لنفسه ومقتصد فهي مشتملة على تلك الأقسام وزيادة
قالوا وأما قولكم إن الآثار الدالة على أن الأصناف الثلاثة هم السعداء أهل الجنة ضعيفة لا تقوم بها حجة فجوابه إنها قد بلغت في الكثرة إلى حد يشد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ونحن نسوق منها آثارا غير ما ذكرناه يعلم به كثرتها وتعدد طرقها فروى ابن مردويه في تفسيره من حديث سفيان عن الأعمش عن رجل عن أبي ثابت أن رجلا دخل المسجد فقال اللهم ارحم غربتي وآنس وحشتي وسق لي جليسا صالحا فقال أبو الدرداء إن كنت صادقا لأنا أسعد بذلك منك سمعت رسول الله قرأ هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قال أما السابق بالخيرات فيدخله الجنة بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله الهم والحزن ثم يدخل الجنة ثم قرأ هذه الأية الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن أسامة بن زيد في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد قال
رسول الله كلهم من هذه الأمة وروى ابن مردويه أيضا من حديث الفضل بن عميرة القيسي عن ميمون بن سياه عن أبي عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر سمعت رسول الله يقول سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له وقرأ عمر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات وروى أيضا من حديث أبي داود عن شعبة عن الوليد بن العيزار قال سمعت رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد أن النبي قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قال كلهم في الجنة أو قال كلهم بمنزلة واحدة قال شعبة أحدهما ورواه داود بن إبراهيم عن شعبة به وقالوا دخلوا الجنة كلهم بمنزلة واحدة فهذا حديث صحيح إلى شعبة وإذا كان شعبة في حديث لم يطرح بل شد يديك به ورواه يحيى بن سعيد عن الوليد بن العيزار فذكره بمثله وروى محمد بن سعد عن أبيه عن عمه حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس
في قوله عز و جل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية قال جعل الله أهل الإيمان على ثلاث منازل كقوله واصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون فهم على هذا المثال قلت يريد ابن عباس أن الله قسم أصحاب اليمين إلى ثلاث منازل كما قسم الخلق في الواقعة إلى ثلاث منازل فإن أصحاب الشمال المذكورين في الواقعة هم الكفار المنكرون للبعث فكيف تكون هذه منزلة من منازل أهل الإيمان ويجوز أن يريد أن الظالمين لأنفسهم المستحقين للعذاب هم من أهل الشمال ولكن إيمانهم يجعلهم آخرا من أهل اليمين وروى من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية فقال هم أمة محمد ورثهم الله كل كتاب أنزله فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب
حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب وروي من حديث عثمان بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن عبدالرحمن بن أبي ليلى حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى حدثنا أبي عن الحكم بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أو عن رجل عن البراء بن عازب قال قال رسول الله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال كلهم ناج وهي هذه الأمة ورواه الفريابي حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن رجل حدثه عن البراء قال قال رسول الله في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية قال كل ناج وقال آدم ابن أبي إياس حدثنا أبو فضالة عن الأزهري عبدالله الخزار حدثنا من سمع عثمان بن عفان يقول ألا إن سابقنا أهل جهادنا ألا وإن مقتصدنا أهل حضرنا ألا وإن ظالمنا أهل بدونا وقد تقدم حديث عائشة وأبي الدرداء وحفيده قالوا فهذه الآثار يشد بعضها بعضا وأنها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وسياق الآية يشهد لها بالصحة فلا نعدل عنها
والمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم إياها فلنرجع إليه فنقول أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء متزودين غضب الرب سبحانه ومعاداة كتبه ورسله وما بعثوا به ومعاداة أوليائه والصد عن سبيله ومحاربة من يدعو إلى دينه ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس وإقامة دعوة غير دعوة الله التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضد ما يحبه الله ويرضاه وأما السائرون إليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإيثار شهواته ولذاته على مراضي الرب سبحانه وأوامره مع إيمانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر لكن نفسه مغلوبة معه مأسورة مع حظه وهواه يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله فهذا حال المسلم وأما من زين له سوء عمله فرآه حسنا وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلا فهذا لا يكاد إسلامه أن يكون صحيحا أبدا ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان ونعوذ بالله من الخذلان
وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاةكما أمره الله فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس فيركع الضحى ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد فأدي فريضته كما أمر مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب
والحرص على الدنيا وعاجلها قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وحببت إليه لقاء الله ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله فهو مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة هذا وهم في ذلك كله مراعون لحفظ السنن لا يخلون منها شيء ما أمكنهم فيقبصدون من الوضور أكمله ومن الوقت أوله ومن الصفوف أولها عن يمين الإمام أو خلف ظهره ويأتون بعد الفريضة بألأذكار المشروعة كالاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وقول
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله ولا نعبد إلاإياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون تسعا وتسعين ويختمون المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
ومن أراد المزيد قرأ آية الكرسي والمعوذتين عقيب كل صلاة فإن فيها أحاديث رواها النسائي وغيره ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه هذا دأبهم في كل فريضة
فإذا كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار المساء الواردة في السنة نظير أذكار الصباح الواردة في أول النهار لا يخلون بها أبدا
فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قسمها بين عباده
فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة وهي كثيرة تبلغ نحوا من أربعين فليأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه من قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا ثم يمسحون بها رؤوسهم ووجوههم
وأجسادهم ثلاثا ويقرأون آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة ويسبحون ثلاثا وثلاثين ويحمدون ثلاثا وثلاثين ويكبرون أربعا وثلاثين ثم
يقول أحدهم اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليه لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبقيك الذي أرسلت
وإن شاء قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين
وإن شاء قال اللهم رب السموات السبع ورب العرض العظيم ربي ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر
وبالجملة فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم هو يذكر الله فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله
فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى وتشييع الجنائز وإجابة الدعوة والمعاونة لهم بالجاه والبدن والنفس والمال وزيارتهم وتفقدهم وقائم بحقوق أهله وعياله فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره فهذا وظيفته دائما
وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به بل ما شممنا له رائحة ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة منها أن لا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها ومنها أن لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى ذليلا له حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرمين ومنها أنه عساه أن تنهض همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد ومنها أنه لعله أن يصدق في الرغبة واللجاء إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه ومنها أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد أشرف منه وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا يناسب النفوس الدنيئة المهينة فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأقله فليبشر بالخير فقد أهل له فليقل لنفسه يا نفس فقد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخر فإن السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به فقد قطعت نصف المسافة فهلا تقطعين باقيها فتفوزين فوزا عظيما ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل فإذا كان اثنان أحدهما
عالم بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به وآخر جاهل به غير متصف به فهو خلو من الأمرين فلا ريب أن العالم به خير من الجاهل وإن كان العالم المتصف به خيرا منهما فينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه وينزل في مرتبته ومنها أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه فلا بد أن ينال منه بحسب استعداده ولو لحظة ولو بارقة ولو أنه يحدث نفسه بالنهضة إليه ومنها أنه لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غيره بقصده أو بغير قصده والله لا يضيع مثقال ذرة فعسى أن يرحم بذلك العامل وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر فلا ينبغي أن تصغي إلى من يثبطك عنه وتقول إنه لا ينفع بل احذره واستعن الله ولا تعجز ولكن لا تغتر وفرق بين العلم والحال وإياك أن تظن أن بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهله هيهات ما أظهر الفرق بين العلم بوجوه الغنى وهو فقير وبين الغني بالفعل وبين العالم بأسباب الصحة وحدودها وهو سقيم وبين الصحيح بالفعل فاسمع الآن وصف القوم وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخرهم الجليل فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل فالطريق واضح والباب مفتوح
إذا أعجبتك خصال امرىء ... فكنه تكن مثل ما يعجبك
فليس على الجود والمكرما ... ت إذا جئتها حاجب يحجبك
فنبأ القوم عجيب وأمرهم خفي إلا على من له مشاركة مع القوم فإنه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبق فليها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب قد أنساهم حبه ذكر غيره وأوحشهم أنسهم به ممن سواه قد فنا بحبه عن حب من سواه وبذكره عن ذكر من سواه وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل
والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى وأسماءه الحسنى ومشاهدا له في اسمائه وصفاته قد تجلت على قلبه أنوارها فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته
فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء وقيل لبعض العارفين أيسجد القلب بين يدي ربه قال أي والله بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة ولم يقف عند رسم ولا سكن إلى علم حتى دخل على ربه في داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده وتصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم فيأمر فيها بما يشاء فينزل الأمر من عنده نافذا فيشاهد الملك الحق قيوما بنفسه مقيما لكل ما سواه غنيا عن كل من سواه وكل من سواه فقير إليه يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر ضعيفا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره حيث يقول في الحديث الصحيح يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع فيشاهده
كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم فيشهده وحده القيوم بأمر السموات والأرض ومن فيهن ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به إليه ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده ولا معين له فيعاونه على قضائها أحاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحمة فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما ولا يشغله منها شأن عن شأن ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كلا منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخيط البحر إذا غمس فيه ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ذلك بأنه الغني الجواد الماجد فعطاؤه كلام وعذابه من كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ويشهده كما أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق حيث يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه وبالجملة فيشهده في كلامه فقد تجلى سبحانه وتعالى لعباده في كلامه وتراءى لهم فيه وتعرف إليهم فيه فبعدا وتبا للجاحدين
والظالمين أفي الله شك فاطر السموات والأرض9 لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه أنسته ذكر غيره وشغلته عن حب من سواه وحديث دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فيه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله ومن غلظ حجابه وكثف طبعه وصلب عوده فهو عن فهم هذا بمعزل بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به تعالى من حلول أو اتحاد أو يفهم منه غير المراد منه فيحرف معناه ولفظه ومن لم يجعل الله له نوارا فماله من نور وقد ذكرت معنى الحديث والرد على من حرفه وغلط فيه في كتاب التحفة المكية وبالجملة فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرشا للمثل الأعلى أي عرشا لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه وناهيك بقلب هذا شأنه فيا له من قلب من ربه ما أدناه ومن قربه ما أحظاه فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيره فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش وأبدانهم في فرشهم كما قال أبو الدرداء إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش فإن كان طاهرا أذن لها في السجود وإن كان جنبا لم يؤذن لها بالسجود
وهذا والله أعلم هو السر الذي لأجله أمر النبي الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ وهو إما واجب على أحد القولين أو مؤكد الاستحباب على القول الآخر فإن الوضوء يخفف حدث الجنابة ويجعله طاهرا من بعض الوجوه ولهذا روى الإمام أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما عن أصحاب رسول الله إنهم إذا كان أحدهم جنبا ثم اراد أن يجلس في المسجد توضى ثم جلس فيه وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره مع أن المساجد لا تحل لجنب على أن وضوءه رفع حكم الجنابة المطلقة الكاملة التي تمنع الجنب من الجلوس في بيت الله وتمنع الروح من السجود بين يدي الله سبحانه فتأمل هذه المسألة وفقهها واعرف مقادر فقه الصحابة وعمق علومهم فهل ترى أحدا من المتأخرين وصل إلى مبلغ هذا الفقه الذي خص الله به خيار عباده وهم أصحاب نبيه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوا الفضل العظيم فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعد إلى الله بهمه وحبه وأشواقه مشتاقا إليه طالبا له محتاجا إليه عاكفا عليه فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى النفس والطعام والشراب فإذا نام غاب عنه فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه وإلى الشوق الشديد والحب المقلق فحبيبه آخر خطراته عند منامه وأولها عند استيقاظه كما قال بعض المحبين لمحبوبه
وآخر شيء أنت في كل هجعة ... وأول شيء أنت عند هبوبي
فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحبة وشروطها فإذا كان هذا في محبة مخلوق لمخلوق فما الظن في محبة المحبوب الأعلى فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة فصل فإذا استيقظ أحدهم إلى قلبه هذا الشأن فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به أن لا يخلي بينه وبين نفسه وأن لا يكله إليها فيكله إلى ضعة وعجز وذنب وخطيئة بل يكلؤه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فأول ما يبدأ به الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور متدبرا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت وأعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات أو الأذى والتي هو غرض وهدف لسهامها كلها تقصده بالهلاك أو الأذى والتي من بعضها شياطين الإنس والجن فإنها تلتقي بروحه إذا نام فتصد إهلاكه وأذاه فلولا أن الله سبحانه يدفع عنه لما سلم هذا ويلقي الروح في تلك الغيبة من أنواع الأذى والمخاوف والمكاره والتفريعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها لتلك الأرواح فمن الناس من يشعر إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع
والوجع الروحي الذي ربما غلب حتى سرى إلى البدن ومن الناس من تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك فهي مثخنة بالجراح مزمنة بالأمراض ولكن لنومها لا تحس بذلك هذا وكم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام وغيرها وقد حفظه منه فهي في أحجارها محبوسة عنه لو خليت وطبعها لأهلكته فمن ذا الذي كلأه وحرسه وقد غاب عنه حسه وعلمه وسمعه وبصره فلو جاءه البلاء من أي مكان جاء لم يشعر به ولهذا ذكر سبحانه عباده هذه النعمة وعدها عليهم من جملة نعمه فقال من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون فإذا تصور العبد ذلك فقال الحمد لله كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك ثم تفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الإماته حيا سليما قادرا على أن يعيده بعد موتته الكبرى حيا كما كان ولهذا يقول بعدها وإليه النشور ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكب ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم يدعو ويتضرع ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه ثم يصلي ما كتب الله صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه لا صلاة مدل بها عليه يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره واستزاره وطرد غيره وأهله وحرم غيره فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته سروره في تلك الصلاة فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع
الفجر كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك فهو كما قيل
يود أن ظلام الليل دام له ... وزيد فيه سواد القلب والبصر
فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم ويناجيه بكلامه معطيا لكل آية حظها من العبودية فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد والآيات التي فيها الأسماء والصفات والآيات التي تعرف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب كما قيل
وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى ... إلى غاية ما بعدها لي مذهب
فلما تلاقينا وعاينت حسنها ... تيقنت أني إنما كنت ألعب
فوا أسفاه وواحسرتاه كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فصل فإذا صلى ما كتب الله جلس مطرقا بين يدي ربه هيبة له وإجلالا واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ويرحمه
فإذا قضى من الاستغفار وطرا وكان عليه بعد ليل اضطجع على شقه الأيمن مجما نفسه مريحا لها مقويا على أداء وظيفة الفرض فيستقبله نشيطا بجده وهمته كأنه لم يزل طول ليلته لم يعمل شيئا فهو يريد أن يستدرك ما فاته في صلاة الفجر فيصلي السنة ويبتهل إلى الله بينها وبين الفريضة فإن لذلك الوقت شأنا يعرفه من عرفه ويكثر فيه من قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت فلهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجيب ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصد الصف الأول عن يمين الإمام أو خلف قفاه فإن فاته ذلك قصد القرب منه مهما أمكن فإن للقرب من الإمام تأثيرا في سر الصلاة ولهذا القرب تأثير في صلاة الفج خاصة يعرفه من عرف قوله تعالى وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا قيل يشهده الله عز و جل وملائكته وقيل يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود أولئك فيجتمعون في صلاة الفجر وذلك لأنها هي أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل فيشهده ملائكة الليل والنهار واحتج لهذا القول بما في الصحيح من حيث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر لقول أبي هريرة واقرؤوا إن شئتم وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا رواه البخاري في الصحيح قال أصحاب القول الأول وهذا لا ينافي قولنا وهو أن يكون الله سبحانه وملائكة الليل والنهار يشهدون قرآن الفجر وليس المراد الشهادة العامة فإن الله على كل شيء شهيد بل المراد شهادة خاصة وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو الرب ونزوله إلى سماء
الدنيا في الشطر الأخير من الليل وقد روى الليث بن سعد حدثني زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله قال إن الله عز و جل ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي يم يره غيره فيمحو الله ما يشاء ويثبت ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاث وهم النبيون والصديقون والشهداء ثك يقول وطوبى لمن دخلك ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه ملائكته فتنتفض فيقول قومي بعزتي ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر فأغفر له ألا من سائل يسألني فأعطيه ألا داع يدعوني فأجيبه حتى تكون صلاة الفجر ولذلك يقول الله عز و جل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا يشهده الله عز و جل وملائكته ملائكة الليل والنهار ففي هذا الحديث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر وعلى هذا
فيكون شهوده سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار له وهذه خاصة بصلاة الصبح ليست لغيرها من الصلاة وهذا لا ينافي دوام النزول في سائر الأحاديث إلى طلوع الفجر ولا سيما وهو معلق في بعضها على انفجار الصبح وهو اتساع ضوئه وفي لفظ حتى يضيء الفجر وهذا دليل لفظ حتى يسطع الفجر وذلك هو وقت قراءة الفجر وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبي وخلفائه الراشدين على تقديمها في أول وقتها فكان النبي يقرأ فيها بالستين إلى المائة ويطيل ركوعها وسجودها وينصرف منها والنساء لا يعرفن من الغلس وهذا لا يكون إلا مع شدة التقديم في أول الوقت لتقع القراءة في وقت النزول فيحصل الشهود المخصوص مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث مصرحا به دوام ذلك إلى الانصراف من صلاة الصبح رواه الدارقطني في كتاب نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قال ينزل الله عز و جل إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث الآخر يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارىء من صلاة الصبح رواه عن محمد جماعة منهم
سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر والدراوردي وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبدالوهاب بن عطاء ومحمد بن جعفر والنضر بن شميل كلهم قال أو ينصرف القارىء من صلاةالفجر فإن كانت هذه اللفظة محفوظة عن النبي فهي صريحة في المعنى كاشفة للمراد وإن لم تكن محفوظة وكانت من شك الراوي هل قال هذا أو هذا فقد قدمنا أنه لا منافاة بين اللفظين وأن حديث الليث بن سعد عن محمد بن زيادة يدل على دوام النزول إلى وقت صلاة الفجر وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي يكون فيه الصعود كما رواه يونس بن أبي إسحق عن أبيه عن الأغر أبي مسلم قال شهدت على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي أنه قال إن الله عز و جل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت ثم قال هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مستغيث أغيثه هل من مضطر أكشف عنه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا ثم يصعد إلى السماء قال الدارقطني فزاد فيه يونس بن أبي إسحق زيادة حسنة والمقصود ذكر القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتها والله أعلم
فصل
فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكار التي شرعت أول النهار فيجعلها وردا له لا يخل بها أبدا ثم يزيد عليها ما شاء من الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلع الشمس فإذا طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء وإن شاء قام من غير ركوع ثم يذهب متضرعا إلى ربه سائلا له أن يكون ضامنا عليه متصرفا في مرضاته بقية يومه فلا ينقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضاة ربه وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية وقصد الاستعانة به على مرضاة الرب وبالجملة فيقف عند أول الداعي إلى فعله فيفتش ويستخرج منه منفذا ومسلكا يسلك به إلى ربه فينقلب في حقه عبادة وقربة وشتان كم بين هذا وبين من إذا عرض له أمر من أوامر الرب لا بد له من فعله وفتش فيه على مراد نفسه وغرض لطبعه ففعل لأجل ذلك وجعل الأمر طريقا له منفذا لمقصده فسبحان من فاوت بين النفوس إلى هذا الحد والغاية فهذا عباداته عادات والأول عاداته عبادات فإذا جاء فرض الظهر بادر إليه مكملا له ناصحا فيه لمعبوده كنصح المحب الصادق المحبة
لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئا ما فهو لا يبقي مجهودا بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإكماله ليقع موقعا من محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده أن لا يكون في عمله هكذا وهو يرى المحبين في أشغال محبوبيهم من الخلق كيف يجتهدون على أحسن وجه وأكمله بل هو يجد من نفسه ذلك مع من يحبه من الخلق فلا أقل من أن يكون مع ربه بهذه المنزلة ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحى من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه وهو يعلم من نفلسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه نصحه ولم يدع من حسنه شيئا إلا فعله
وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه فهو أبدا إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم وقال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فأمر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة وشرع للمتوضىء أن يقول بعد وضوئه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذه توبة بعد الوضوء وتوبة بعد الحج وتوبة بعد الصلاة وتوبة بعد قيام الليل فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار كما تبين فهو لا يزال
مستغفرا تائبا وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره فصل وجماع الأمر في ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله في الظاهر والباطن فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله وكمال عبودية العبد موافقته لربه في محبته ما أحبه وبذل الجهد في فلعه وموافقته في كراهة ما كرهه وبذل الجهد في تركه وهذا إنما يكون للنفس المطمئنة لا للأمارة ولا للوامة فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل وأما من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال له شهود خاص فيها مطابق لما جاء به الرسول لا مخالف له فإن بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف ويكون مع ذلك قائما بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها وهذا سلوك الأكياس الذين هم خلاصة العالم والسالكون على هذا الدرب أفراد من العالم طريق سهل قريب موصل طريق آمن أكثر السالكين في غفلة عنه ولكن يستدعي رسوخا في العلم ومعرفة تامة به وإقداما على رد الباطل المخالف له ولو قاله من قاله وليس عند أكثر الناس سوى رسوم تلقوها عن قوم معظمين عندهم ثم لإحسان ظنهم بهم قد وقفوا عند أقوالهم ولم يتجاوزوها فصارت حجابا لهم وأي حجاب فمن فتح الله عليه بصيرة قلبه وإيمانه حتى خرقها وجاوزها إلى مقتضى الوحي والفطرة والعقل فقد أوتي خيرا كثيرا ولا يخاف عليه إلا من ضعف همته فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همة عالية فذاك السابق حقا واحد الناس بزمانه لا يلحق شأوه ولا يشق غباره فشتان ما بين من يتلقى أحواله ووارداته عن الأسماء والصفات وبين من يتلقاها عن الأوضاع الاصطلاحية والرسوم أو عن مجرد ذوقه ووجده إذا استحسن شيئا قال هذا هو الحق فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر
السحاب وليس العجب من سائر في ليله ونهاره وهو في الثرى لم يبرح من مكانه وإنما العجب من ساكن لا يرى عليه أثر السفر وقد قطع المراحل والمفاوز فسائر قد ركبته نفسه فهو حاملها وسائر بها ملبوك يعاقبها وتعاقبه ويجرها وتهرب منه ويخطو بها خطوة إلى أمامه فتجذبه خطوتين إلى ورائه فهو معها في جهد وهي معه كذلك وسائر قد ركب نفسه وملك عنانها فهو يسوقها كيف شاء وأين شاء لا تلتوي عليه ولا تنجذب ولا تهرب منه بل هي معه كالأسير الضعيف في يد مالكه وآسره وكالدابة الريضة المنقادة في يد سائسها وراكبها فهي منقادة معه حيث قادها فإذا رام التقدم جمزت به وأسرعت فإذا أرسلها سارت به وجرت فلي الحلبة إلى الغاية ولا يردها شيء فتسير به وهو ساكن على ظهرها ليس كالذي نزل عنها فهو يجرها بلجامها ويشحطها ولا تنشحط فشتان ما بين المسافرين فتأمل هذا المثل فإنه مطابق لحال السائرين المذكورين والله يختص برمحمته من يشاء فصل ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبيره تعالى واختياره بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كله فلا يزاحم تدبيرهم تدبيره ولا اختيارهم اختياره لتيقنهم أنه الملك القاهر القابض على نواصي الخلق المتولي تدبير أمر العالم كله وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصريفه أمور عباده ولو كان كذا وكذا ولا بعسى ولعل ولا بليت بل ربهم أجل وأعظم في قلوبهم من أن يعترضوا عليه أو يتسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواه وهو أعلم به وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره أو يظنوا به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله بل هو ناظر بعين قلبه إلى بارىء الأشياء وفاطرها
ناظر إلى إتقان صنعه مشاهد لحكمته فيه وإن لم يخرج ذلك على مكاييل عقول البشر وعوائدهم ومألوفاتهم قال بعض السلف لو قرض جسمي بالمقاريض أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضه وقال آخر أذنبت ذنبا أبكي عليه منذ ثلاثين سنة وكان قد اجتهد في العبادة قيل له وما هو قال قلت مرة لشيء كان ليته لم يكن وبعض العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها بمنزلة العيب لصانعها وخالقها لأنها صنعه وأثر حكمته وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء وهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين له في كل شيء حكمة بالغة وفي كل مصنوع صنع متقن والرجل إذا عاب صنعة الرب سبحانه بلا إذنه سرى ذلك إلى الصانع لأنه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرها إذا كانت الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها ولا صنع له في خلقها فالعارف لا يعيب إلا ما عابه الله ولا يذم إلا ما ذمه وإذا سبق إلى قلبه ولسانه عيب مالم يعبه الله وذم ما لم يذمه الله تاب إلى الله منه كما يتوب صاحب الذنب من ذنبه فإنه يستحي من الله أن يكون في داره وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيها فهو يرى نفسه بمنزلة رجل دخل إلى دار ملك من الملوك ورأى ما فيها من الآلات والبناء والترتيب فأقبل يعيب منها بعضها ويذمه ويقول لو كان كذا بدل كذا لكان خيرا ولو كان هذا في مكان هذا لكان أولى وشاهد الملك يولي ويعزل ويحرم ويعطي فجعل يقبول لو ولي هذا مكان فلان كان خيرا ولو عزل هذا المتولي لكان أولى ولو عوفي هذا ولو أغنى هذا فكيف يكون مقت الملك لهذا المعترض وإخراجه له من قربه وكذلك لو أضافه صاحب له فقدم إليه طعاما فمجعل يعيب صفته ويذمه أكان ذلك يهون على صاحب الطعام قالت عائشة وما عاب رسول الله طعاما قط إن اشتهى شيئا أكله وإلا تركه والمقبصود أن ما شأن القوم ترك
الاهتمام بالتدبير والاختيار بل همهم كله في إقامة حقه عليهم وأما التدبير العام والخاص فقد سلموه لولي الأمر كله ومالكه الفعال لما يريد ولعلك تقول من ذا الذي ينازع الله في تدبيره فلانظر إلى نفسك في عجزها وضعفها وجهلها كيف هي عرضت للمنازعة منازعة جاهل عاجز ضعيف لو قدر لظهرت منه العجائب فسبحان من أذله بعجزه وضعفه وجهله وأراه العبر في نفسه لو كان ذا بصر كيف هو عاجز القدرة جبار الإرادة عبد مربوب مدبر مملوك ليس له من الأمر شيء وهو مع ذلك ينازع الله ربوبيته وحكمته وتدبيره لا يرضى بما رضي الله به ولا يسكن عند مجاري أقداره بل هو عبد ضعيف مسكين يتعاطى الربوبية فقير مسكين في مجموع حالاته ويرى نفسه غنيا جاهل ظالم ويرى نفسه عارفا محسنا فما أجهله بنفسه وبربه وما أتركه لحقه وأشد إضاته لحظه ولو أحضر رشده لرأى ناصيته ونواصي الخلائق بيد الله سبحانه وتعالى يخفلضها ويرفعها كيف يشاء وقلوبهم بيده سبحانه وفي قبضته يقلبها كيف يشاء يزيغ منها من يشاء ويقيم من يشاء ولكان هذا غالبا على شهود قلبه فيغيب به عن مشيئاته وإرادته واختياره ولعرف أن التدبير والركون إلى حول العبد وقوته من الجهل بنفسه وبربه فينفي العلم بالله الجهل عن قلبه فتمحي منه الإرادات والمشيئات والتدبيرات ويفوضها إلى مالك القلوب والنواصي فيصير بذلك عبدا لربه تقلبه يد القدرة ويصير ابن وقته لا ينتظر وقتا آخر يدبر فيه نفسه لأن ذلك الوقت بيد موقته فيرى نفسه بمنزلة
الميت في قبره ينتظر ما يفعل به مستسلم لله منقطع المشيئة والاختيار هذا ما يجري على أحدهم من فعل الله وحكمه وقضائه الكوني فإذا جاء الأمر جاءت الإرادة والاختيار والجد والسعي واستفراغ الفكر وبذل الجهد فهو قوي حي فعال يشاهد عبودية مولاه في أمره فهو متحرك فيه بظاهره وباطنه قد أخرج مقدوره من القوة إلى الفعل وهو مع ذلك مستعين بربه قائم بحوله وقوته ملاحظ لضعفه وعجزه قد تحقق بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين فهو ناظر بقلبه إلى مولاه الذي حركه مستعين به في أن يوفقه لما يحبه ويرضاه عينه في كل لحظة شاخصة إلى حقه المتوجه عليه لربه ليؤديه في وقته على أكمل أحواله فإذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها من العبودية وهم فيها على مراتب ثلاثة إحداها الرضا عنه فيها والمزيد من حبه والشوق إليه وهذا نشأ من مشاهدتهم للطفه فيها وبره وإحسانه العاجل والآجل ومن مشاهدتهم حكمته فيها ونصبها سببا لمصالحهم وشوقهم بها إلى حبه ورضوانه ولهم من ذلك مشاهد أخر لا تسعها العبارة وهي فتح من الله على العبد لا يبلغه علمه ولا عمله المرتبة الثانية شكره عليها كشكره علىالنعم وهذا فوق الرضا عنه بها ومنه ينتقل إلى هذه المرتبة فهذه مرتبتان لأهل هذا الشأن والثالثة للمقتصدين وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى نقصان الإيمان وفواته من التسخط والتشكي واستبطاء الفرج واليأس من الروح والجزع الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة فالصبر أول منازل الإيمان ودرجاته وأوسطها وآخرها فإن صاحب الرضا والشكر لا يعدم الصبر في مرتبته بل الصبر معه وبه يتحقق الرضا والشكر لا تصور ولا تحقق لهما دونه وهكذا كل مقام مع الذي فوقه كالتوكل مع الرضا وكالخوف والرجاء مع الحب فإن المقام لا ينعدم بالترقي إلى الآخر ولو
عدم لخلفه ضده وذلك رجوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس المذمومة وإنما يندرج حكمه في المقام الذي أعلى منه فيصير الحكم له كما ينيدرج مقام التوكل في مقام المحبة والرضا وليس هذا كمنازل سير الأبدان الذي إذا قطع منها منزلا خلفه وراء ظهره واستقبل المنزل الآخر معرضا عن الأول بارتحاله بل هذا كمنزلة التاجر الذي كلما باع شيئا من ماله وربح يه ثم باع الثاني وربح فقد ربح بهما معا وهكذا أبدا يكون ربحه في كل صفقة متضاعفا بانضمامه إلى ما قبله فالربح الأول اندرج في الثاني ولم يعدم فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه يزل عنك ما يعرض من الغلط في علل المقامات وتعلم أن دعوى المدعي أنها من منازل العوام ودعوى أنها معلولة غلط من وجهين أحدهما أن أعلى المقامات مقرون بأدناها مصاحب له كما تقدم متضمن له تضمن الكل لجزئه أوم مستلزم له استلزام الملزوم للازمه لا ينفك عنه أبدا ولكن لاندراجه فيه وانطواء حكمه تحته يصير المشهد والحكم للعالي الوجه الثاني أن تلك المقامات والمنازل إنما هي منازل العوام وتعرض لها العلل بحسب متعلقاتها وغاياتها فإن كان متعلقها وغاياتها بريئا من شوائب العلل وهو أجل متعلق وأعظمه فلا علة فيها بحال وهي من منازل الخواص من جهة تعلقها بحظه ولنذكر لذلك أمثلة المثال الأول الإرادة فإن الله جعلها من منازل صفوة عباده وأمر رسوله أن يصبر نفلسه مع أهلها فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال حكاية عن أوليائه قولهم إنما نطعمكم لوجه الله وهي لام التعليل الداخلة على
الغايات المرادة وهي كثيرة في القرآن فقالت طائفة والإرادة حلية العوام وهي تجريد القصد وجزم النية والجد في الطلب وذلك غيره في طريق الخواص تفرق ورجوع إلى النفس فإن إرادة العبد عين حظه وهو رأس الدعوى وإنما الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريد كقوله تعالى وإن يردك بخير فلا راد لفضله فيكون مراده ما يراد به واختياره ما اختيرله إذ لا إرادة للعبد مع سيده ولا نظر كما قال
أريد وصاله ويريد هجري ... فأترك ما أريد لما يريد
ومن هذا قول أبي يزيد قيل لي ما تريد قلت أريد أن لا أريد لأني أنا المراد وأنت المريد فيقال ليس المراد من العوام في كلامهم العامة الجهال وإنما مرادهم بهذه اللفظة عموم السالكين دون أهل الخصوص الواصلين منازل الفناء وعين الجمع وإذا عرف هذا فالكلام على ما ذكر في الأرادة من وجوه
أحدها أن الإرادة هي مركب العبودية وأساس بنائها الذي لا تقوم إلا عليه فلا عبودية لمن لا إرادة له بل أكمل الخلق أكملهم عبودية ومحبة وأصحهم حالا وأقومهم معرفة وأتمهم إرادة فكيف يقال إنها حلية العوام أو من منازل العوام
الوجه الثاني أنه يلزم من هذا أن تكون المحبة من منازل العوام
وتكون معلولة أيضا لأنها إرادة تامة للمحبوب ووجود المحبة بلا إرادة كوجود الإنسانية من غير جيوانية وكوجود مقام الأحسان بدون الإيمان والسلام فإذا كانت الإرادة معلولة وهي من منازل العوام لزم أن تكون المحبة كذلك فإن قيل المحبة التي لا علة فيها هي تجرد المحب عن الإرادة وفناؤه بإرادة محبوبه عن إرادته قيل هذا هو حقيقة الإرادة أن يبقى مراده مراد محبوبه فلو لم يكن مريدا لمراد محبوبه لم يكن موافقا له في الإرادة والمحبة هي موافقى المحبوب في إرادته فعاد الأمر إلى ما أشرنا إليه أن المعلول من ذلك ما تعلق بحظ المريد دون محبوبه فإذا صارت إرادته موافقة لإرادة محبوبه لم تكن تلك الإرادة من منازل العوام ولا معلولة بل هذه أشرف منازل الخواص وغاية مطالبهم وليس وراءها إلا التجرد عن كل إرادة والفناء بشهوده عن إرادةما يريد وهذا هو الذي يشير إليه السالكون إلى منازل الفناء ويجعلونه غاية الغايات وهذا عند أهل الكمال نقص وتغيير في وجه المحبة وهضم لجانب العبودية وفناء بحظ المحب من مشاهدته جمال محبوبه وفنائه فيه عن حق المحبوب ومراده فهو الوقوف مع نفس الحظ والهروب عن حق المحبوب ومراده وهل مثل هذا إلا كمثل رجلين ادعيا محبة ملك فحضرا بين يديه فقال ما تريدان فقال أحدهما أريد أن لا أريد شيئا بل أفنى عن إرادتي وأكون أنا المراد وأنت تريد بي ما تشاء وقال الآخر أريد أن أنفق أنفاسي وذراتي في محابك ومرضاتك منفذا لأوامرك مشمرا في طاعتك أتوجه حيث توجهني وأفعل ما تأمرني هذا الذي أريده فقال الآخر وأنا أريد منك أن تفعل مثل هذا فإني سأبعثكما في أشغالي ومهماتي فأما أحدهما فقال لا حظ لي سوى اتباع مرضاتك والقيام بحقوقك وقال الآخر لا أريد إلا مشاهدتك والنظر إليك والفناء فيك فهل يكونان في نظره سواء وهل تستوي منزلتهما عنده ولو أمعنوا النظر لعلموا أن صاحب الفناء هو طالب حظ الواقف معه وأن الآخر وإن لم ينسلخ من الحظ ولكن حظه مراد المحبوب منه لا
مراده هو من المحبوب وبين الأمرين من الفرق كما بين الأرض والسماء فالعجب ممن يفضل صاحب الحظ الذي يريده من محبوبه على من صار حظه مراد محبوبه منه بل الفناء الكامل أن يفنى بإرادته عن إرادة من سواه وبحبه عن حب ما سواه وبرجائه عن رجاء ما سواه وبخشيته عن خشية ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه ليس أن تفنى بحطك منه عن مراده منك وهذا موضع يشتبه علما وحالا وذوقا إلا على من فتح الله عليه بفرقان بين هذا وهذا
الوجه الثالث أن الإرادة إنما تكون ناقصة بحسب نقصان المراد فإذا كان مرادها أشرف المرادات فإرادته أشرف الإرادات ثم إذا كانت الوسيلة إليه أجل الوسائل وأنفعها وأكملها فإرادتها كذلك فلا تخرج إرادته عن إرادة أشرف الغايات وإرادة أقرب الوسائل إليه وأنفعها فأي علة في هذه الإرادة وأي شيء فوقها للخواص
الوجه الرابع أن نقصان الشيء يكون من وجهين أحدهما أن يوجب ضررا والثاني أن تكون له ثمرة نافعة لكن يشغل عما هو أكمل منه وكلاهما منتف عن الإرادة فكيف تكون ناقصة معلولة فإن قيل لما كان الوقوف معها رجوعا إلى النفس وتفرقا ووقوفا مع حظ المريد كانت ناقصة قيل هذا منشأ الغلط
وجوابه بالوجه الخامس وهو أن يقال قوله إن الإرادة تفرق فإن أردتم بالتفرق شهود المريد لإرادته ولمراده ولعبوديته ولمعبوده ولمحبته ولمحبوبه فلم قلتم إن هذا التفرق نقص وهل هذا إلا عين الكمال وهل تتم العبودية إلا بهذا فإن من شهد عبوديته وغاب بها عن معبوده كان محبوبا ومن شهد المعبود وغاب به عن شهود عبوديته وقيامه بما أمره به كان ناقص العبودية ضعيف الشهود وهل الكمال إلا شهود المعبو مع شهود عبادته فإنها عين حقه ومراده ومحبوبه من عبده فهل يكون شهود العبد
لحق محبوبه ومراده منه وأنه قائم به ممتثل له نقصا ويكون غيبته عن ذلك وإعراضه عنه وفناؤه عن شهوده كمالا وهل هذا إلا قلب للحقائق فغاية صاحب هذا الحال والمقام أن يكون معذورا بضيق قلبه عن شهود هذا إما لضعف المحل أو لغلبة الوارد وعجزه عن احتمال شيء آخر معه فأما أن يكون هذا هو الكمال المطلوب والآخر نقص فكلا وأين مقام من يشهد عبوديته ومنة الله عليه فيها وتوفيقه لها وجعهل محلا وآلة وهو ناظر مع ذلك إلى معبوده بقلبه شاهدا له فانيا عن شهود غيره في عبوديته من مقام من لا يتسع لهذا وهذا وتأمل حال أكمل الخلق وأفضلهم وأشدهم حبا لله كيف كان في عبادته جامعا بين الشهودين حتى كان لا يغيب عن أحوال المأمومين فضلا عن شهود عبادته وكان يراعي أحوالهم وهو في ذلك المقام بين يدي ربه سبحانه فالكلمة من أمته على منهاجه وطريقته في ذلك فالواجب التمييز بين المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه فقد جعل الله لكل شيء قدرا وإن أردتم بالتفرق شتات القلب في شعاب الحظوظ وأودية الهوى فهذه الإرادة لا تستلزم شيئا من ذلك بل هي جمعية القلب على المحبوب وعلى محابه ومراداته ومثل هذا التفرق هو عين البقاء ومحض العبودية ونفس الكمال وما عداه فمحض حظ العبد لا حق محبوبه
الوجه السادس أن قوله إن الإرادة رجوع إلى النفس وإن إرادة العبد عين حظه كلام فيه إجمال وتفصيل فيقال ما تريدون بقولكم إن الإرادة رجوع إلى النفس أتريدون أنها رجوع عن إرادة الرب وإرادة محابة إلى إرادة النفس وحظوظها أم تريدون أنها رجوع إلى إرادة النفس لربها ولمرضاته فإن أردتم الأول علم أن هذه الإرادة معلولة ناقصة فاسدة ولكن ليست هذه الإرادة التي نتكلم فيها وإن أردتم المعنى الثاني فهو عين الكمال وإنما النقصان خلافه
الوجه السابع أن قولكم إن هذه الإرادة عين حظ العبد قلنا نعم هي أكبر حظ له وأجله وأعظمه وهل العبد حظ أشرف من أن يكون الله وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومراده فهذا هو الحظ الأوفر والسعادة العظمى ولكن لم قلتم إن اشتغال العبد لهذا الحظ نقص في حقه وهل فوق هذا كمال فيطلبه العبد ثم يقال لو كان فوقه شيء أكمل منه لكان اشتغال العبد به وطلبه إياه اشتغالا بحظه أيضا فيكون ناقصا فأين الكمال فإن قلتم في تركه حظوظه كلها قيل لكم وتركه هذا الحظ أيضا هو من حظوظه فإنه يبقى معطلا فارغا من الإرادة أصلا بل لا بد له من إرادة ومراد وكل إرادة لكم رجوع إلى الحظ فأي اشتغال به وبإرادته كان وقوفا عن حظه فيالله العجب متى يكون عبدا محضا خالصا لربه
ويوضح هذا الوجه الثامن أن الحي لا ينفك عن الإرادة ما دام شاعرا بنفسه وإنما ينفك عنها إذا غاب عنه شعوره بعارض من العوارض فالإرادة من لوازم الحياة فدعوى أن الكمال في التجرد عنها دعوى باطلة مستحيلة طبعا وحسا بل الكمال في التجرد عن الإرادة التي تزاحم مراد المحبوب لا عن الإرادة التي توافق مراده
الوجه التاسع قوله الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريد إلخ فيقال هذا على نوعين أحهما ما يراد بالعبد من المقدور الذي يجري عليه بغير اختياره كالفقر والغنى والصحة والمرض والحياة والموت وغير ذلك فهذا لا ريب أن الكمال فناء العبد فيه عن إرادته ووقوفه مع ما يراد به لا يكون له إرادة تزاحم إرادة الله منه كحال الثلاثة الذين قال أحدهم أنا أحب الموت للقاء الله وقال الآخر أحب البقاء لطاعته وعبادته فقال الثالث غلطتما ولكن أنا أحب من ذلك ما يحب فإن كان يحب إماتتي أحببت الموت وإن كان يحب حياتي أحببت الحياة
فأنا أحب ما يحبه من الحياة والموت فهذا أكل وأصح حالا فيما يراد بالعبد والنوع الثاني ما يراد من العبد من الأوامر والقربات فهذا ليس الكمال إلا في إرادته وإن فرقته فهو مجموع في تفرقته متفرق في جمعيته وهذا حال الكملة من الناس متفرق الإرادة في الأمر مجتمع على الأمر فهو مجموع عليه متفرق فيه ولا يكون فعل المرادات المختلفة بإرادة واحدة بالعين وإنما غايتها أن تكون هنا إرادتان إحداهما إرادة واحدة للمراد المحبوب والثانية إرادات متفرقة لحقه ومحابه وما أمر به فهي وإن تعددت وتكثرت فمرجعها إلى مراد واحد بإرادة كلية وكل فعل منها له إرادة جزئية محضة
الوجه العاشر أن قول أبي يزيد أريد أن لا أريد تناقض بين فإنه قد أراد عدم الإرادة فإذا قال أريد أن لا أريد يقال له فقد أردت وأحسن من هذا أن يكون الجواب أريد ما يريد لا ما أريد وإذا كان لا بد من إرادة ففرق بين الإرادتين إرادة سلب الإرادة وإرادة موافقة المحبوب في مراده والله أعلم
الوجه الحادي عشر أنه فسر الإرادة بتجريد القصد وجزم النية والجد في الطلب وهذا هو عين كمال العين وهو متضمن للصدق والإخلاص والقيام بالعبودية فأي نقص في تجريد القبصد وهو تخليصه من كل شائبة نفسانية أو طبيعية وتجريده لمراد المحبوب وحده والجد في طلبه وطلب مرضاته وجزم النية وهو أن لا يعتريها وقفة ولا تأخير وهذا الأمر هو غاية منازل الصديقين وصديقية العبد بحسب رسوخه في هذا المقام وكلما ازداد قربه وعلا مقامه قوي عزمه وتجرد صدقه فالصادق لا نهاية لطلبه ولا فتور لقصده بل قصده أتم وطلبه أكمل ونيته أحزم قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هنا الموت باتفاق علماء
الإسلام فجاءه إذ جاءه وإرادته وقصده ونيته في الذروة العليا ونهاية كمالها وتمامها فأين العلة في هذه الإرادة ولكن العلة والنقص في الإرادة التي يكون مصدرها النفس والهوى وغايتها نيل حظ المريد من محبوبه وإن كان المحبوب يريد ذلك لكن غيره أحب إليه منه وهو أن يكون مراده محض حق محبوبه وحصول مرضاته فانيا عن حظه هو من محبوبه بل قد صار حظه منه نفس حقه ومراده فهذه هي الإرادة والمحبة التي لا علة فيه ولا نقص نسأل الله تعالى أن يمن علينا ويحيينا ولو بنفس منها كما من بتعليمها ومعرفتها إنه جواد كريم
الوجه الثاني عشر أنه قال بعد هذا فصحة الإرادة بذل الوسع واستفراغ الطاقة مع ترك الاختيار والسكون إلى مجاري الأقدار فيكون كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء فأين هذا من قوله وذلك في طريق الخواص نقص وتفرق وهل يكون بذل الوسع واستفراغ الطاقة إلا مع تمام الإرادة وإنما الذي يفرض له النقص من الإرادة نوعان أحدهما إرادة مصدرها طلب الحظ والثاني اختياره فيما يفعل به بغير اختياره فعن هاتين الإرادتين ينبغي الفناء وفيهما يكون النقص فالكمال ترك الاختيار فيهما والسكون إلى مراد المحبوب وحقه في الأولى وإلى مجاري أقداره وحكمه في الثانية فيكون في الأولى حيا فعالا منازعا لقواطعه عن مراد محبوبه وفي الثانية كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء وبهذا التفصيل ينكشف سر هذه المسألة ويحصل التمييز بين محض العبودية وحظ النفس والله الموفق للصواب فصل المثال الثاني الزهد قال أبو العباس هو للعوام أيضا
لأنه حبس النفس عن الملذوذات وإمساكها عن فضول الشهوات ومخالفة دواعي الهوى وترك مالا يغني من الأشياء وهذا نقص في طريق الخاصة لأنه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادها وتعذيب للظاهر بتركها مع تعلق الباطن بها والمبالاة بالدنيا عين الرجوع إلى ذاتك وتضييع الوقت في منازعة نفسك وشهود جنسك وبقائك معك ألا ترى إلى من أعطاه الله الدنيا بحذافيرها كيف قال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وذلك حيث عافى باطنه من شهودها وظاهره من التعلق بها فالزهد صرف الرغبة إليه وتعلق الهمة به والاشتغال به عن كل شيء يشغل عنه ليتولى هو حسم هذه الأسباب عنك كما قيل إن بعض المريدين سأل بعض المشايخ فقال أيها الشيخ بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة فقال الشيخ إني لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه نحن قوم صرفنا هممنا إلى الله فكفانا ما دونه وكما قال
تسترت عن دهري بظل جناحه ... فعيني ترى دهري وليس يراني
فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت ... وأين مكاني ما عرفن مكاني
فيقال الكلام على هذا من وجوه أحداها أن جعل الزهد للعوام لما ذكره إنما يتم إذا كان الزهد ملزوما لمنازعة النفس ومجاذبتها لدواعي الشهوة والهوى وحينئذ فيكون قلبه مشغولا بتلك الدواعي والجواذب ونفسه تطالبه بها وزهده يأمره باجتنابها ولا ريب أن فوق هذا مقاما أعلى منه وهو طمأنينة نفسه وسكونها إلى محبوبها وانجذاب دواعيها إلى محابه ومرضاته وهذا للخواص من المؤمنين ولكن هذه المنازعة غير لازمة للزهد وإن كان لا بد منها في حكم الطبيعة لتحقق الابتلاء والامتحان وليتحقق ترك العبد حظه وهواه لربه إيثارا له على هواه ونفسه الثاني أنه لو كانت هذه المنازعة وحبس النفس عن الملذوذات من لوازم الزهد لم يكن فيها
نقص ولا علة فإنها من لوازم الطبيعة وأحكام الجبلة وهي كالجوع والعطش والألم والتعب فحبس النفس عن إجابة دواعيها إيثارا لله ومرضاته عليها لا يكون نقصا ولا مستلزما لنقص وقد اختلف أرباب السلوك هنا في هذه المسألة وهي أيهما أفضل من له داعية وشهوة وهو يحبسها لله ولا يطيعهما حبا له وحياء منه وخوفا أو من لا داعية له تنازعه بل نفسه خالية من تلك الدواعي والشهوة قد اطمأنت إلى ربها واشتغلت به عن غيره وامتلأت بحبه وإرادته فليس فيها موضع لإرادة غيره ولا حبه فرجحت طائفة الأول وقالت هذا يدل على قوة تعلقه وشدة محبته فهو يعاصي دواعي الطبع والشهوة ويقهرها بسلطان محبته وإرادته وخوفه من الله وهذا يدل على تمكنه من نفسه وتمكن حاله مع الله وغلبة داعي الحق عنده على داعي الطبع والنفس قالوا وأيضا فله مزيد في حاله وإيمانه بهذا الإيثار والترك مع حضور داعي الفعل عنده ومزيد مجاهدة عدوه الباطن ونفسه وهواه كما يكون له مزيد مجاهدة عدوه الظاهر قالوا والذوق والوجد يشهد لمزيده من الحب والأنس والسرور والفرح بربه عن إيثاره على دواعي الهوى والنفس والمطمئن الذي ليس فيه هذا الداعي ليس له مزيد من هذه الجهة وإن كان مزيده من جهة أخرى فهي مشتركة بينهما ويختص هذا بمزيده من الإيثار والمجاهدة قالوا وأيضا فهذا مبتلى بهذه الدواعي والإرادات وذلك معافى منها وقد جرت سنة الله في المؤمنين من عباده أن يبتليهم على حسب إيمانهم فمن ازداد إيمانه زيد في بلائه كما ثبت عن النبي أنه قال يبتلى المرء على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء والمراد بالدين
هنا الإيمان الذي يثبت عند نوازل البلاء فإن المؤمن يبتلى على قدر ما يحمله إيمانه من وراء البلاء قالوا فالبلاء بمخالفة دواعي النفس والطبع من أشد البلاء فإنه لا يصبر عليه إلا الصديقون وأما البلاء الذي يجري على العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والطش ونحوها فالصبر عليه لا يتوقف على الإيمان بل يصبر عليه البر والفاجر لا سيما إذا علم أنه لا معول له إلا الصبر فإنه إن لم يصبر اختيارا صبر اضطرارا ولهذا كان بين ابتلاء يوسف الصديق بما فعل به إخوته من الأذى والإلقاء في الجب وبيعه بيع العبيد والتفريق بينه وبين أبيه وابتلائه بمراودة المرأة وهو شاب عزب غريب بمنزلة العبد لها وهي الداعية إلى ذلك فرق عظيم لا يعرفه إلا من عرف مراتب البلاء فإن الشباب داع إلى الشهوة والشاب قد يستحي من أهله ومارفه من قضاء وطره فإذا صار في دار الغربة زال ذلك الاستحياء والاحتشام وإذا كان عزبا كان أشد لشهوته وإذا كانت المرأة هي الطالبة كان أشد وإذا كانت جميلة كان أعظم فإن كانت ذات منصب كان أقوى في الشهوة فإن كان ذلك في دارها وتحت حكمها بحيث لا يخاف الفضيحة ولا الشهرة كان أبلغ فإن استوثقت بتغليق الأبواب والاحتفاظ من الداخل كان أقوى أيضا للطلب فإن كان الرجل كمملوكها وهي كالحاكمة عليه الآمرة الناهية كان أبلغ في الداعي فإذا كانت المرأة شديدة العشق والمحبة للرجل قد امتلأ قلبها من حبه فهذا الابتلاء الذي صبر معه مثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله عليهم أجمعين ولا ريب أن هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء الأول بل هو من جنس ابتلاء الخليل بذبح ولده إذ كلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع ودواعي النفس والشهوة ومفارقة حكم طبعه وهذا بخلاف البلوى التي أصابت ذا النون والتي أصابت أيوب قالوا وأيضا فإن هذه هي النكتة التي من أجلها كان صالح البشر أفضل من الملائكة لأن الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب دواعي النفس والشهوات البشرية فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق وهي
كالنفس للحي وأما عبادات البشر فمع منازعات النفوس وقمع الشهوات ومخالفة دواعي الطبع فكانت أكمل ولهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم على الملائكة لهذا المعنى ولغيره فمن لم يخلق له تلك الدواعي والشهوات فهو بمنزلة الملائكة ومن خلقت له وأعانه الله على دفعها وقهرها وعصيانها كان أكمل وأفضل قالوا وأيضا فإن حقيقة المحبة إيثار المحبوب ومرضاته على ما سواه قالوا وكيف يصح الإيثار ممن لا تنازعه نفسه وطبعه إلى غير المحبوب قالوا وليس العجب من قلب خال عن الشهوات والإرادات قد ماتت دواعي طبعه وشهوته إذا عكف على محبوبه ومعبوده واطمأن إليه واجتمعت همته وإنما العجب من قلب قد ابتلي بما ابتلي من الهوى والشهوة ودواعي الطبيعة مع قوة سلطانها وغلبتها وضعفه وكثرة الجيوش التي تغير على قلبه كل وقت إذا آثر ربه ومرضاته على هواه وشهوته ودواعي طبعه فهو هارب إلى ربه من بين تلك الجيوش وعاكف عليه في تلك الزعازع والأهوية التي تغشى على الأسماع والأبصار والأفئدة يتحمل منها لأجل محبوبه مالا تتحمله الجبال الراسيات قالوا وأيضا فنهي النفس عن الهوى عبودية خاصة لها تأثير خاص وإنما يحصل إذا كان ثم ما ينهي عنه النفس قالوا وأيضا فالهوى عدو الإنسان فإذا قهر عدوه وصار تحت قبضته وسلطانه كان أقوى وأكمل ممن لا عدو له يقهره قالوا ولهذا كان حال النبي في قهره قرينه حتى انقاد وأسلم له فلم يكن يأمره إلا بخير أكمل من حال عمر حيث كان الشيطان إذا رآه يفر
منه وكان إذا سلك فجأ سلك غير فجه وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو كيف لا يقف الشيطان لعمر بل يفر منه ومع هذا قد تفلت على النبي وتعرض له وهو في الصلاة وأراد أن يقطع عليه الصلاة ومعلوم أن حال الرسول أكمل وأقوى والجواب ما ذكرناه أن شيطان عمر كان يفر منه فلا يقدر أحدهما على قهر صاحبه وأما الشيطان الذي تعرض للنبي فقد أخذه وأسره وجعله في قبضته كالأسير وأين من يهرب منه عدوه فلا يظفر به إلى من يظفر بعدوه فيجعله في أسره وتحت يده وقبضته فهذا ونحوه مما احتج به أرباب هذا القول
واحتج أرباب القول الثاني وهم الذين رجحوا من لا منازعة في طباعه ولا هوى له يغالبه بأن قالوا كيف تستوي النفس المطمئنة إلى ربها العاكفة على حبه التي لا منازعة فيها اصلا ولا داعية تدعوها إلى الإعراض عنه والنفس المشغولة بمحاربة هواها ودواعيها وجواذبها قالوا وأيضا ففي الزمن الذي يشتغل هذا بنفسه ومحاربة هواه وطبعه يكون صاحب النفس المطمئنة قد قطع مراحل من سيره وفاز بقرب فات صاحب المحاربة
والمنازعة قالوا كما لو كان رجلان مسافرين في طريق فطلع على أحدهما قاطع اشتغل بدفعه عن نفسه ومحاربته ليتمكن من سيره والآخر سائر لم يعرض له قاطع بل هو على جادة سيره فإن هذا يقطع من المسافة أكثر مما يقطع الأول ويقرب إلى الغاية أكثر من قربه قالوا وأيضا فإن للقلب قوة يسير بها فإذا صرف تلك القوة في دفع العوارض والدواعي القاطعة له عن السير اشتغل قلبه بدفها عن السير في زمن المدافعة
قالوا ولأن المقصود بالقصد الأول إنما هو السير إلىالله والاشتغال بدفع العوارض مقصود لغيره فالاشتغال بالمقصود لنفسه أولى وأفضل من الاشتغال بالوسيلة قالوا وأيضا فالعوارض المانعة للقلب من سيره هي من باب المرض واجتماع القلب على الله وطمأنينته به وسكونه إليه بلا منازع ولا جاذب ولا معارض هو صحته وحياته ونعيمه فكيف يكون القلب الذي يعرض له مرض وهو مشغل بدوائه أفضل من القلب الذي لا داء به ولا علة قالوا وأيضا فهذه الدواعي والميول والإرادات التي في القلب تقتضي جذبه وتعويقه عن وجه سيره وما فيه من داعي المحبة والإيمان يقتضي حذبه عن طريقها فتتعارض الجواذب فإن لم توقفه عوقته ولا بد فأين السير بلا معوق من السير مع المعوق
قالوا وأيضا فالذي يسير العبد بإذن ربه إنما هو همته والهمة إذا علت وارتفعت لم تلحقها القواطع والآفات كالطائر إذا علا وارتفع في الجو فات الرماة ولم يلحقه الحصا ولا البنادق ولا السهام وإنما تدرك هذه الأشياء للطائر إذا لم يكن عاليا فكذلك الهمة العالية قد فاتت الجوارح والكواسر وإنما تلحق الآفات والدواعي والإرادات الهمة النازلة فأما إذا علت فلا تلحقها الآفات قالوا وأيضا فالحس والوجود شاهد بأن قلب المحب متى خلا من غير المحبوب واجتمعت شؤونه كلها على محبوبه ولم يبق فيه التفات إلى غيره كان أكمل محبة من القلب الملتفت إلى الرقباء المهتم بمحاربتهم ومدافعتهم والهرب منهم والتواري عنهم قالوا فكم بين
محب يجتاز على الرقباء فيطرقون من هيبته وخشيته ولا يرفع أحد منهم رأسه إليه وبين محب إذا اجتاز بالرقباء هاشوا عليه كالزنابير أو الكلاب فاشتغل بدفعهم وحرابهم أو جد في الهرب منهم فكيف يسوي هذا بهذا أن كيف يفضل عليه مع هذا التباين قالوا وأيضا فالمحبة الخالصة الصادقة حقيقتها أنها نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب وإذا احترق ما سوى مراده عدم وذهب أثره فإذا بقي في القلب شيء من سوى مراده لم تكن المحبة تامة ولا صادقة بل هي محبة مشوبة بغيرها فالمحب الصادق ليس في قلبه سوى مراد محبوبه حتى ينازعه ويدافعه والآخر في قلبه بقية لغير المحبوب فهو جاهد على إخراجها وإعدامها قالوا وأيضا فالواردات الإلهية ترد على القلوب على قدر استعدادها وقبولها فإذا صادفت القلب خاليا فارغا من العوارض والمنازعات ودواعي الطبع والهوى ملأته على قدر فراغه وإذا امتلأ منها لم يبق لأضدادها وأعدائها فيه مسلك وإذا صادفت فيه موضعا مشغولا بغير من الأغيار لم يساكن ذلك الموضع فيدخل الضد والعدو من تلك الثلمة كما قال القائل
لا كان من لسواك فيه بقية ... يجد السبيل بل إليه العذل
وقال
ومهما بقي للصحو فيه بقية ... يجد نحوك اللاحي سبيلا إلى العذل
قالوا وأيضا فدواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتها مصدرها إما جهل وإما ضعف فإنها لا تصدر إلا من جهل العبد بأثارها وموجباتها أو يكون عالما بذلك لكن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوها من قلبه بالكلية وما كانت سببه جهلا أو عجزا لا يكون كمالا ولا مستلزما لكمال وأما القلب الخالي منها ومن الاشتغال بدفعها فقلب شريف قوي علوي رفيع قالوا وأيضا فهذه الإرادات والدواعي لا تسير العبد بل إما أن تنكسه إن أجابها وإما أن تعوقه وتوقفه إن اشتغل بمدافعتها وأما إرادات القلب السليم منها
والنفس المطمئنة بربها فكل إرادة منها تسير به مراحل على مهله فهو يسير رويدا وقد سبق السعادة كما قيل
من لي بمثل سيرك المذلل ... تمشي رويدا وتجي في الأول
قالوا وأيضا فإن هذه الدواعي والإرادات إنما تحمد عاقبتها إذا ردت صاحبها إلى حال السليم منها فيكون كماله في تشبهه به وسيره معه فكيف يكون أكمل ممن كماله إنما هو في تشبهه به قالوا وأيضا فالنفوس ثلاثة أمارة ولوامه ومطمئنة والنفس الأمارة هي المطيعة لدواعي طباعها وشهواتها فمبادىء كونها أمارة هي تلك الدواعي والإرادات فتستحكم فتصير عزمات ثم توجب الأفعال فمبدأ صفة الذم فيها تلك الدواعي وأما النفس المطمئنة فهي التي عدمت هذه المبادىء فعدمت غاياتها فكيف تكون مباي النفس الأمارة مما يوجب لها مزية على النفس المطمئنة فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة أيضا لقولها
والحق أن كلا الطائفتين على صواب من القول لكن كل فرقة لحظت غير ملحظ الفرقة الآخرى فكأنهما لم يتواردا على محل واحد بل الفرقة الأولى نظرت إلى نهاية سير المجاهد لنفسه وإرادته وما ترتب له عليها من الأحوال والمقامات فأوجب لها شهود نهايته رجحانه فحكمت بترجيحه واستحلت بتفضيله والفرق ةالثانية نظرت إلى بدايته في شأنه ذلك ونهاية النفس المطمئنة فأوجب لها شهود الأمرين الحكم بترجيح القلب الخالي من تلك الدواعي ومجاهدتها كل واحدة من الطائفتين قد أدلت بحجج لا تمانع وأتت ببينات لا ترد ولا تدافع وفصل الخطاب في هذه المسألة يظهر بمسألة يرتضع معها من لبانها ويخرج من مشكاتها وهي أن العبد إذا كان له حال أو مقام مع الله ثم نزل عنه إلى ذنب ارتكبه ثم تاب من ذنبه هل يعود إلى مثل ما كان أو لا يعود بل إن رجع رجع إلى أنزل من مقامه وأنقص من رتبته أو يعود خيرا مما كان فقالت طائفة يعود بالتوبة إلى مثل حاله الأولى فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا
محي أثر الذنب بالتوبة صار وجوده كعدمه فكأنه لم يكن فيعود إلى مثل حاله قالوا ولأن التوبة هي الرجوع إلى الله بعد الإباق منه فإن المعصية إباق العبد من ربه فإذا تاب إلى الله فقد رجع إليه وإذا كان مسمى التوبة هو الرجوع فلو لم يعد إلى حالته الأولى مع الله لم تكن توبته تامة والكلام إنما هو في التوبة النصوح قالوا ولأن التوبة كما ترفع اثر الذنب في الحال بالإقلاع عنه وفي المستقبل بالعزم على أن لا يعود فكذلك ترفع أثره في الماضي جملة ومن أثره في الماضي انحطاط منزلته عند الله ونقصانه عنده فلا بد من ارتفاع هذا الأثر بالتوبة وإذا ارتفع بها عاد إلى مثل حاله قالوا ولأنه لو بقي نازلا من مرتبته منحطا عن منزلته بعد التوبة كما كان قبلها لم تكن التوبة قد محت أثر الذنب ولا أفادت في الماضي شيئا وإن عاد إلى دون منزلته ولم يبلغها فبلوغه تلك الدرجة إنما كان بالتوبة فلو ضعف تأثير التوبة عن إعادته إلى منزلته الأولى لضعف عن تبليغه تلك المنزلة التي وصل إليها وإن لم تكن التوبة ضعيفة التأثير عن تبليغه تلك المنزلة لم تكن ضعيفة التأثير عن إعادته إلى المنزلة الأولى قالوا وأيضا ربط سبحانه الجزاء بالأعمال ربط الأسباب بمسبباتها فالجزاء من جنس العمل فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تاما رجع الله عليه بمنزلته وحاله بل ما رجع العبد إلى الله حتى رجع بقلبه إليه أولا فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيا فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله توبة منه إذنا وتمكينا تاب بها العبد وتاب الله عليه قبولا ورضى فتوبة العبد بين توبتين من الله وهذا يدل على عنايته سبحانه وبره ولطفه بعبده التائب فكيف يقال إنه لا يعيده مع هذا اللطف والبر إلى حاله قالوا وأيضا فإن التوبة من أجل الطاعات وأوجبها على المؤمنين وأعظمها غناء عنهم وهم إليها أحوج من كل شيء وهي من أحب الطاعات إلى الله فإنه يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله وإذا كانت بهذه المثابة فالآتي بها آت بما هو من أفضل القربات وأجل الطاعات فإذا كان قد حصل له بالمعصية انحطاط ونزول مرتبة فبالتوبة يحصل له مزيد تقدم وعلو
درجة فإن لم تكن درجته بعد التوبة أعلى فإنها لا تكون أنزل قالوا وأيضا فإنا إذا قابلنا بين جناية المعصية والتقرب بالتوبة وجدنا الحاصل من التوبة أرجح من الأثر الحاصل من المعصية والكلام إنما هو في التوبة النصوح الكاملة وجانب الفضل أرجح من جانب العدل ولهذا كان في جانب العدل آحاد بآحاد وجانب الفضل آحاد بعشرات إلى سبعمائة إلى اضعاف كثيرة وهذا يدل على رجحان جانب الفضل وغلبته وكذلك مصدرهما من الغضب والرحمة فإن رحمة الرب تغلب غضبه قالوا وأيضا فالذنب بمنزلة المرض والتوبة بمنزلة العافية والعبد إذا مرض ثم عوفي وتكاملت عافيته رجعت صحته إلى ما كانت عليه بل ربما رجعت أقوى وأكمل مما كانت عليه لأنه ربما كان معه في حال العافية آلام وأسقام كامنة فإذا اعتل ظهت تلك الأسقام ثم زالت بالعافية جملة فتعود قوته خيرا مما كانت وأكمل وفي مثل هذا قال الشاعر
لعل عتبك محمود عواقبه ... وربما صحت الأجسام بالعلل
وهذا الوجه هو أحد ما احتج به من قال إنه يعود بالتوبة خيرا مما كان قبل التوبة واحتجوا لقولهم أيضا بأن التوبة تثمر للعبد محبة من الله خاصة لا تحصل بدون التوبة بل التوبة شرط في حصولها وإن حصل له محبة أخرى بغيرها من الطاعات فالمحبة الحاصلة له بالتوبة لا تنال بغيرها فإن الله يحب التوابين ومن محبته لهم فرحه بتوبة أحدهم أعظم فرح وأكمله فإذا أثمرت له التوبة هذه المحبة ورجع بها إلى طاعاته التي كان عليها أولا انضم أثرها إلى أثرتلك الطاعات فقوي الأثران فحصل له المزيد من القرب والوسيلة وهذا بخلاف ما يظنه من نقصت معرفته بربه من أنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا يعود الود الذي كان له منه قبل الجناية واحتجوا في ذلك بأثر إسرائيلي مكذوب أن الله قال داود عليه السلام يا داود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يعود وهذا كذب قطا فإن الود يعود بعد التوبة النصوح أعظم مما كان فإنه سبحانه يحب التوابين ولو لم
بعد الود لما حصلت له محبته وأيضا فإنه يفرح بتوبة التائب ومحال أن يفرح بها أعظم فرح وأكمله وهو لا يحبه وتأمل سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالى إنه هو يبدىء ويعيد وهو الغفور الودودو تجد فيه من الرد والإنكار على من قال لا يعود الود والمحبة منه لعبده أبدا ما هو من كنوز القرآن ولطائف فهمه وفي ذلك ما يهيج القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكفا على ربه الذي لا إله إلا هو ولا رب له سواه عكوف المحب الصادق على محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغيره أبدا واحتجوا أيضا بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة لأن الذنب يحدث له من الخوف والخشية والانكسار والتذلل لله والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته والندم عليها والأسف والإشفاء ما هو من أفضل أحوال العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون أسبابها إذ حصول الملزوم بون لازمه محال والله يحب من عبده كسرته وتضرعه وذله بين يديه واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه وخطيئته فإذا قضى عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار المحبوبة له كان ذلك القضاء خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ولهذا قال بعض السلف
لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه ... لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه
وقيل إن في بعض الآثار يقول الله تعالى لداود عليه السلام يا داود كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك قالوا وقد قال غير واحد من السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة قالوا ولهذا قال سبحانه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب فزاده على المغفرة أمرين الزلفى
وهي درجة القرب منه وقد قال فيها سلف الأمة وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراخهم ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف والثاني حسن المآب وهو حسن المنقلب وطيب المأوى عند الله قالوا ومن تأمل زيادة القرب التي أعطيها داود بعد المغفرة علم صحة ما قلنا وأن العبد بعد التوبة يعود خيرا مما كان قالوا وأيضا فإن للعبودية لوازم وأحكاما وأسرارا وكمالات لا تحصل إلا بها ومن جملتها تكميل مقام الذل للعزيز الرحيم فإن الله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل له وهذه هي حقيقة العبودية واشتقاقها يدل على ذلك فإن العرب تقول طريق معبد أي مذلل بوطء الأقدام والذل أنواع أكملها ذل المحب لمحبوبه الثاني ذل الملوك لمالكه الثالث ذل الجاني بين يدي المنعم عليه المحسن إليه المالك له الرابع ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليها التي هي في يده وبأمره وتحت هذا قسمان أحدهما ذل له في أن يجلب له ما ينفعه والثاني ذل له في أن يدفع عنه ما يضره على الدوام ويدخل في هذا ذل المصائب كالفقر والمرض وأنواع البلاء والمحن فهذه خمسة أنواع من الذل إذا وفاها العبد حقها وشهدها كما ينبغي وعرف ما يراد به وقام بين يدي ربه مستصحبا لها شاهدا لذله من كل وجه ولعزة ربه وعظمته وجلاله كان قليل أعماله قائما مقام الكثير من أعمال غيره قالوا وهذه أسرار لا تدرك بمجرد الكلام فمن لا نصيب له منها فلا يضره أن يخلي المطي وحاديها ويعطي القوس باريها
فللكثافة أقوام لها خلقوا ... وللمحبة أكباد وأجفان
قالوا وأيضا فقد ثبت عن النبي أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته قالوا وهذا أعظم ما يكون من الفرح
وأكمله فإن صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والشراب وهي مركبه الذي يقطع به مسافة سفره فلو عدمه لانقطع في طريقه فكيف إذا عدم مع مركبه طعامه وشرابه ثم إنه عدمها في أرض دوية لا أنيس بها ولا معين ولا من يأوي له ويرحمه ويحمله ثم إنها مهلكة لا ماء بها ولا طعام فلما أيس من الحياة بفقدها وجلس ينتظر الموت إذا هو براحلته قد أشرفت عليه ودنت منه فأي فرحة تعدل فرحة هذا ولو كان في الوجود فرح أعظم من هذا لمثل به النبي ومع هذا ففرح الله بتوبة عبده إذ تاب إليه أعظم من فرح هذا براحلته وتحت هذا سر عظيم يختص الله بفهمه من يشاء فإن كنت ممن غلظ حجابه وكثفت نفسه وطباعه فعليك بوادي الخفا وهو وادي المحرفين للكلم عن مواضعه الواضعين له على غير المراد منه فهو واد قد سلكه خلق وتفرقوا في شعابه وطرقه ومتاهاته و لم تستقر لهم فيه قدم ولا لجأوا منه إلى ركن وثيق بل هم كحاطب الليل وحاطم السيل وإن نجاك الله من هذا الوادي فتأمل هذه الألفاظ النبوية المعصومة التي مقصود المتكلم بها غاية البيان مع مصدرها عن كمال العلم بالله وكمال النصيحة للأمة ومع هذه المقامات الثلاث أعني كمال بيان المتكلم وفصاحته وحسن تعبيره عن المعاني وكمال معرفته وعلمه بما يعبر عنه وكمال نصحه وإرادته لهداية الخلائق يستحيل عليه أن يخاطبهم بشيء وهو لا يريد منهم ما يدل عليه خطابه بل يريد منه أمرا بعيدا عن ذلك الخطاب إنما يدل عليه كدلالة الألغاز والأحاجي مع قدرته على التعبير عن ذلك المعنى بأحسن عبارة وأوجزها فكيف يليق به أن يعدل عن مقتضى البيان الرافع للإشكال المزيل للإجمال ويوقع الأمة في أودية التأويلات وشعاب الاحتمالات والتجويزات سبحانك هذا بهتان عظيم وهل قدر الرسول حق قدره أو مرسله حق قدره من نسب كلامه سبحانه أو كلام رسوله إلى مثل ذلك ففصاحة الرسول وبيانه وعلمه ومعرفته ونصحه وشفقته يحيل عليه أن يكون مراده من كلامه ما يحمله عليه
المحرفون للكلم عن مواضعه المتأولون له غير تأويله وأن يكون كلامه من جنس الألغاز والأحاجي والحمد لله رب العالمين
فإن قلت فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي ذممته فتسلك فيه أو من طريق يستقيم عليه السالك قلت نعم بحمد الله الطريق واضحة المنار بينة الأعلام مضيئة للسالكين وأولها أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالمين فإن هذه العقدة هي أصل بلاء الناس فمن حلها فما بعدها أيسر منها ومن هلك بها فما بعدها أشد منها وهل نفى أحد ما نفى من صفات الرب ونعوت جلاله إلا لسبق نظره الضعيف إليها واحتجاجه بها عن أصل الصفة وتجردها عن خصائص المحدث فإن الصفة يلزمها لوازم باختلاف محلها فيظن القاصر إذا رأى ذلك اللازم في المحل المحدث أنه لازم لتلك الصفة مطلقا فهو يفر من إثباتها للخالق سبحانه حيث لم يتجرد في ظنه عن ذلك اللازم وهذا كما فعل من نفى عنه سبحانه الفرح والمحبة والرضى والغضب والكراهة والمقت والبغض وردها كلها إلى الإرادة فإنه فهم فرحا مستلزما لخصائص المخلوق من انبساط دم القلب وحصول ما ينفعه وكذلك فهم غضبا هو غليان دم القلب طلبا للانتقام وكذلك فهم محبة ورضى وكراهة ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين فإن ذلك هو السابق إلى فهمه وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواه ولم يحط علمه بغيره ولما كان هو السابق إلى فهمه لم يجد بدا من نفيه عن الخالق والصفة لم تتجرد في عقله عن هذا اللازم فلم يجد بدا من نفيها ثم لأصحاب هذه الطريق مسلكان أحدهما مسلك التناقض البين وهو إثبات كثير من الصفات ولا يلتفت فيها إلى هذا الخيال بل يثبتها مجردة عن خصائص المخلوق كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاها يستلزم المحذور الذي فر منه فكيف لم يستلزم إثبات ما أثبته وإن كان إثبات ما أثبته لا يستلزم محذورا فكيف يستلزم إثبات ما نفاه
وهل في التناقض أعجب من هذا والمسلك الثاني مسلك النفي العام والتعطيل المحض هربا من التناقض والتزاما لأعظم الباطل وأمحل المحال فإذا الحق المحض في الإثبات المحض الذي أثبته الله لنفسه في كلامه وعلى لسان رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تبديل ومنشأ غلط المحرفين إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها فينفون ذلك اللازم عن الله فيضطرون في نفيه إلى نفي الصفة ولا ريب أن الأمور ثلاثة أمر يلزم الصفة لذاتها من حيث هي فهذا لا يجب بل لا يجوز نفيه كما يلزم العلم والسمع والبصر من تعلقها بمعلوم ومسموع ومبصر فلا يجوز نفي هذه التعلقات عن هذه الصفات إذ لا تحقق لها بدونها وكذلك الإرادة مثلا تستلزم العلم لذاتها فلا يجوز نفي لازمها عنها وكذلك السمع والبصر والعلم يستلزم الحياة فلا يجوز نفي لوازمها وكذلك كون المرئي مرئيا حقيقة له لوازم لا ينفك عنها ولا سبيل إلى نفي تلك اللوازم إلا بنفي الرؤية وكذلك الفعل الاختياري له لوازم لا بد فيه منها فمن نفى لوازمه نفى الفعل الاختياري ولا بد ومن هنا كان أهل الكلام أكثر الناس تناقضا واضطرابا فإنهم ينفون الشيء ويثبتون ملزومه ويثبتون الشيء وينفون لازمه فتتناقض أقوالهم وأدلتهم ويقع السالك خلفهم في الحيرة والشك ولهذا يكون نهاية أمر أكثرهم الشك والحيرة حاشى من هو في خفارة بلادته منهم أو من قد خرق تلك الخيالات وقطع تلك الشبهات وحكم الفطرة والشرعة والعقل المؤبد بنور الوحي عليها فنقدها نقد الصيارف فنفى زغلها وعلم أن الصحيح منها إما أن يكون قد تولت النصوص بيانه وإما أن يكون فيها غنية عنه بما هو خير منه وأقرب طريقا وأسهل تناولا ولا يستفيد المؤمن البصير بما جاء به الرسول العارف به من المتكلمين سوى مناقضة بعضهم بعضا ومعارضته وإبداء بعضهم عوار بعض ومحاربة بعضهم بعضا فيتولى بعضهم محاربة بعض ويسلم ما جاء به الرسول فإذا رأى
المؤمن العالم الناصح لله ولرسوله أحدهم قد تعدى إلى ما جاء به الرسول يناقضه ويعارضه فليعلم أنهم لا طريق لهم إلى ذلك أبدا ولا يقع ردهم إلا على آراء أمثالهم وأشباههم وأما ما جاء به الرسول فمحفوظ محروس مصون من تطرق المعارضة والمناقضة إليه فإن وجدت شيئا من ذلك في كلامهم فبدار بدار إلى إبداء فضائحهم وكشف تلبيسهم ومحالهم وتناقضهم وتبيين كذبهم على العقل والوحي فإنهم لا يردون شيئا مما جاء به الرسول إلا بزخرف من القول يغتر به ضعيف العقل والإيمان فاكشفه ولا تهن تجده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ولولا أن كل مسائل القوم وشبههم التي خالفوا فيها النصوص بهذه المثابة لذكرنا من أمثلة ذلك ما تقر به عيون أهل الإيمان السائرين إلى الله على طريق الرسول وأصحابه وإن وفق الله سبحانه جردنا لذلك كتابا مفردا وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المقصد في عامة كتبه لا سيما كتابه الذي وسمه ببيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح فمزق فيه شملهم كل ممزق وكشف أسرارهم وهتك أستارهم فجزاه الله عن الإسلام وأهله من أفضل الجزاء واعلم أنه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاء به الرسول بل الشبهة التي يوردها أهل البدع والضلال على أهل السنة لا تخلو من قسمين إما أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول بل تكون نسبته إليه غلطا وهذا لا يكون متفقا عليه بين أهل السنة أبدا بل يكون قد قاله بعضهم وغلط فيه فإن العصمة إنما هي لمجموع الأمة لا لطائفة معينة منها وإما أن يكون القول الذي أوردت عليه قولا صحيحا لكن لا ترد تلك الشبهة عليه وحينئذ فلا بد له من أحد أمرين إما أن تكون لازمة وإما ألا تكون لازمة فإن كانت لازمة لما جاء بها الرسول فهي حق لا شبهة إذ لازم الحق حق ولا ينبغي الفرار منها كما يفعل الضعفاء من المنتسبين إلى السنة بل كل ما لزم من الحق فهو حق يتعين القول به كائنا ما
كان وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق ألزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتها فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوه فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا منها لم يجد أعداؤهم إليهم سبيلا وإن لم تكن لازمة لهم فإلزامهم إياها باطل وعلى النقدين فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم وحينئذ فلهم جوابان مركب مجمل ومفرد مفصل أما الأول فيقولون لهم هذه اللوازم التي تلزمونا بها إما أن تكون لازمة في نفس الأمر وإما أن لا تكون لازمة فإن كانت لازمة فهي حق إذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول فهو الحق الصريح ولازم الحق حق وإن لم تكن لازمة فهي مندفعة ولا يجوز إلزامها وأما الجواب المفصل فيفردون كل إلزام بجواب ولا يردونه مطلقا بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه فإن كان لفظها موافقا لما جاء به الرسول يتضمن إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه فلا يكون المعنى إلا حقا فيقبلون ذلك الإلزام وإن كان مخالفا لما جاء به الرسول متضمنا لنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه كان باطلا لفظا ومعنى فيقابلونه بالرد وإن كان لفظا مجملا محتملا لحق وباطل لم يقبلوه مطلقا ولم يردوه مطلقا حتى يستفسروا قائله ماذا أراد به فإن أراد معنى صحيحا مطابقا لما جاء به الرسول قبلوه ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقا إن أراد معنى باطلا ردوه ولم يطلقوا نفي اللفظ المحتمل أيضا فهذه قاعدتهم التي بها يعتصمون وعليها يعولون وبسط هذه الكلمات يستدعي أسفارا لا سفرا واحدا ومن لا ضياء له لا ينتفع بها ولا بغيرها فلنقتصر عليها ولنعد إلى المقصود فنقول وبالله التوفيق
فرح الرب سبحانه هذا الفرح العظيم بتوبة عبده إذا تاب إليه هو من
ملزومات محبته ولوازمها أعني كونه محبا لعباده المؤمنين محبوبا لهم وإنما خلق خلقه لعبادته المتضمنة لكمال محبته والخضوع له ولهذا خلق الجنة والنار ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وهذا هو الحق الذي خلق به السموات والأرض وأنزل به الكتاب قال تعالى وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إلى قوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق وقوله الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق فهذا أمره وتنزيله مصدره الحق والأول خلقه وتكوينه مصدره الحق أيضا فبالحق كان الخلق والأمر وعنه صدر الخلق والأمر وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبته وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد يحب أن يحمد ويثنى عليه ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى كما قال النبي في الحديث الصحيح لا أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك أثنى على نفسه وفي المسند من حديث الأسود بن سريع أنه قال يا رسول الله إني حمدت ربي بمحامد فقال إن ربك يحب الحمد فهو
يحب نفسه ومن أجل ذلك يثني على نفسه ويحمد نفسه ويقدس نفسه ويحب من يحبه ويحمده ويثني عليه بل كلما كانت محبة عبده له أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتم فلا أحد أحب إليه ممن يحبه ويحمده ويثني عليه ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه لأنه ينقص هذه المحبة ويجعلها بينه وبين من أشرك به ولهذا لا يغفر الله أن يشرك به لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة والتسوية فيها بينه وبين غيره ولا ريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي يسقط بها من عينه وتنقص بها مرتبته عنده إذا كان من المخلوقين فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره في المحبة والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى به ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبدا وعساه أن يتجاوز لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات في حقه ومتى علم بأنه يحب غيره كما يحبه لم يغفر له هذا الذنب ولم يقربه إليه هذا مقتضى الطبيعة والفطرة أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إلهه ومعبوده وبين غيره في هذه العبودية والمحبة قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين إمنوا أشد حبا لله فأخبر سبحانه أن من أحب شيئا دون الله كما يحب الله فقد اتخذه ندا وهذا معنى قول المشركين لمعبوديهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فهذه تسوية في المحبة والتأليه لا
في الذات والأفعال والصفات والمقصود أنه سبحانه يحب نفسه أعظم محبة ويحب من يحبه وخلق خلقه لذلك وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك وأعد الثواب والعقاب لأجل ذلك وهذا هو محض الحق الذي به قامت السماوات والأرض وكان الخلق والأمر فإذا قام به العبد فقد قام بالأمر الذي خلق له فرضي عنه صانعه وبارؤه وأحبه إذ كان يحب ويرضى فإذا صدف عن ذلك وأعرض عنه وأبق عن مالكه وسيده أبغضه ومقته لأنه خرج عما خلق له وصار إلى ضد الحال التي هو لها فاستوجب منه غضبه بدلا من رضاه وعقوبته بدلا من رحمته فكأنه استدعى من رحمته أن يعامله من نفسه بخلاف ما يحب فإنه سبحانه عفو يحب العفو محسن يحب الإحسان جواد يحب الجود سبقت رحمته غضبه فإذا ابق منه العبد وخامر عليه ذاهبا إلى عدوه فقد استدعى منه أن يجعل غضبه غالبا على رحمته وعقوبته على إحسانه وهو سبحانه يحب من نفسه الإحسان والبر والإنعام فقد استدعى من ربه فعل ما غيره أحب إليه منه وهوبمنزلة عبد السوء الذي يحمل أستاذه من المخلوقين المحسن إليه الذي طبيعته الإحسان والكرم على خلاف مقتضى طبيعته وسجيته فأستاذه يحب لطبعه الإحسان وهو بإساءته ولؤمه يكلفه ضد طباعه ويحمله على خلاف سجيته فإذا راجع هذاالعبد ما يحب سيده ورجع إليه وأقبل عليه ورجع عن عدوه فقد صار إلى الحال التي تقتضي محبة سيده له وإنعامه عليه وإحسانه إليه فيفرح به ولا بد أعظم فرح وهذا الفرح هو دليل غاية الكمال والغنى والمجد فليتدبر اللبيب وجود هذا الفرح ولوازمه وملزوماته يجد في طيه من المعارف الإلهية ما لا تتسع له إلا القلوب المهيأة لهذا الشأن المخلوقة له وهذا فرح محسن بر لطيف جواد غني حميد لا فرح محتاج إلى حصول متكمل به مستقيل له من غيره فهو عين الكمال لازم للكمال ملزوم له وألطف من هذا الوجه أن الله سبحانه خلق عباده المؤمنين وخلق كل شيء لأجلهم كما قال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في
الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وكرمهم وفضلهم على كثير ممن خلق فقال ولقد كرمنا بني إدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال لصالحيهم وصفوتهم إن الله اصطفى إدم ونوحا وءال إبراهيم وءال عمران على العالمين وقال لموسى واصطنعتك لنفسي واتخذ منهم الخليلين والخلة أعلى درجات المحبة وقد جاء في بعض الآثار يقول تعالى ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له وفي أثر آخر يقول تعالى ابن آدم خلق تك لنفسي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء فالله سبحانه خلق عباده له ولهذا اشترى منهم أنفسهم وهذا عقد لم يعقده مع خلق غيرهم فيما أخبر به على لسان رسوله ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له وهذا الشراء دليل على أنها محبوبة له مصطفاة عنده مرضية لديه وقدر السلعة يعرف بجلاله قدر مشتريها وبمقدار ثمنها هذا إذا جهل قدرها في نفسها فإذا عرف قدر السلعة وعرف مشتريها وعرف الثمن المبذول فيها علم شأنها ومرتبتها في الوجود فالسلعة أنت والله المشتري والثمن جنته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه في دار الأمن والسلام والله لا يصطفي لنفسه إلا أعز الأشياء وأشرفها وأعظمها قيمة وإذا كان قد اختار العبد لنفسه وارتضاه لمعرفته ومحبته وبنى له دارا في جواره وقربه وجعل ملائكته خدمة يسعون في
مصالحه في يقظته ومنامه وحياته وموته ثم إن العبد أبق عن سيده ومالكه معرضا عن رضاه ثم لم يكفه ذلك حكى حتى خامر عليه وصالح عدوه ووالاه من دونه وصار من جنده مؤثرا لمرضاته على مرضاة وليه ومالكه فقد باع نفسه التي اشتراها منه إلهه ومالكه وجعل ثمنها جنته والنظر إلى وجهه من عدوه وأبغض خلقه إليه واستبدل غضبه برضاه ولعنته برحمته ومحبته فأي مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما في طي هذا الخطاب من سوء هذا العبد وما تعرض له من المقت والخزي والهوان ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إياه إلى العود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى به فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من أسر له العدو محبوبا له واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى محبه اختيارا وطوعا حتى توسد عتبة بابه فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه متوسدا عتبة بابه واضعا خده وذقنه عليها فكيف يكون فرحه به ولله المثل الأعلى ويكفي في هذا المثل الذي ضربه رسول الله لمن فتح الله عين قلبه فأبصر ما في طيه وما في ضمنه وعلم أنه ليس كلام مجاز ولا مبالغة ولا تخييل بل كلام معصوم في منطقه وعلمه وقصده وعمله كل كلمة منه في موضعها ومنزلتها ومقرها لا يتعدى بها عنه ولا يقصر بها والذي يزيد هذا المعنى تقريرا أن محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له سبحانه فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته في قلبه فإنه ألهمه حبه وآثره به فلما أحبه العبد جازاه على تلك المحبة محبة أعظم منها فإنه من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا ومن أتاه مشيا أتاه
هرولة وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق محبة العبد له وإذا تعرض هذا المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي فر من محبه وآثر غيره عليه فإذا عاوده وأقبل إليه وتخلى عن غيره فكيف لا يفرح به محبه أعظم فرح وأكمله والشاهد أقوى شاهد تؤيده الفطرة والعقل فلولم يخبر الصادق المصدوق بما أخبر به عن هذا الأمر العظيم لكان في الفطرة والعقل ما يشهد به فإذا انضافت الشرعة المنزلة إلى العقل المنور فذلك الذي لا غاية له بعده وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فصل ومتى أراد العبد شاهد هذا من نفسه فلينظر إلى الفرحة التي يجدها بعد التوبة النصوح والسرور واللذة التي تحصل له والجزاء من جنس العمل فلما تاب إلى الله ففرح الله بتوبته أعقبه فرحا عظيما وههنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن وهي أن كل تائب لا بد له في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن ولو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم لأجل هذه المحبة والعارف الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذة والحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة فكلما كانت أقوى وأشد كانت الفرحة واللذة أكمل وأتم ولذلك اسباب عديدة منها أن هذه العصرة والقبض دليل على حياة قلبه وقوة استعداده ولو كان قلبه ميتا واستعداده ضعيفا لم يحصل له ذلك وأيضا فإن الشيطان لص الإيمان واللص إنما يقصد
المكان المعمور وأما المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفر منه بشيء فلا يقصده فإذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة دل على أن في قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه وأيضا فإن قوة المعارض والمضاد تدل على قوة معارضته وضده ومثل هذا إما أن يكون رأسا في الخير أو رأسا في الشر فإن النفوس الأبية القوية إن كانت خيرة رأست في الخير وإن كانت شريرة رأست في الشر وأيضا فإن بحسب موافقته لهذا العارض وصبره عليه يثمر له ذلك من اليقين والثبات والعزم ما يوجب لزيادة انشراحه وطمأنينته وأيضا فإنه كلما عظم المطلوب كثرت العوارض والموانع دونه هذه سنة الله في الخلق فانظر إلى الجنة وعظمها وإلى الموانع والقواطع التي حالت دونها حتى أوجبت أن ذهب من كل ألف رجل واحد إليها وانظر إلى محبة الله والانقطاع إليه والإنابة إليه والتبتل إليه وحده والأنس به واتخاذه وليا ووكيلا وكافيا وحسيبا هل يكتسب العبد شيئا أشرف منه وانظر إلى القواطع والموانع الحائلة دونه حتى قد تعلق كل قوم بما تعلقوا به دونه والطالبون له منهم الواقف مع عمله والواقف مع علمه والواقف مع حاله والواقف مع ذوقه وجميعته وحظه من ربه والمطلوب منهم وراء ذلك كله والمقصود أن هذا الأمر الحاصل بالتوبة لما كان من أجل الأمور وأعظمها نصبت عليه المعارضات والمحن ليتميز الصادق من الكاذب وتقع الفتنة ويحصل الابتلاء ويتميز من يصلح ممن لا يصلح قال تعالى الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ءامنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولكن إذا صبر على هذه العصرة قليلا أفضت به إلى رياض الأنس وجنات الانشراح وإن لم
يصبر لها انقلب على وجهه والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه والمقصود أن هذا الفرح من الله بتوبة عبده مع أنه لم يأت نظيره في غيرها من الطاعات دليل على عظم قدر التوبة وفضلها عند الله وأن التعبد له بها من أشرف التعبدات وهذا يدل على أن صاحبها يعود أكمل مما كان قبلها فهذا بعض ما احتج به لهذا القول
وأما الطائفة التي قالت لا يعود إلى مثل ما كان بل لا بد أن ينقص حاله فاحتجوا بأن الجناية توجب الوحشة وزوال المحبة ونقص العبودية بلا ريب فليس العبد الموفر أوقاته على طاعة سيده كالعبد المفرط في حقوقه وهذا مما لا يمكن جحده ومكابرته فإذا تاب إلى ربه ورجع إليه أثرت توبته ترك مؤاخذته بالذنب والعفو عنه وأما مقام القرب والمحبة فهيهات أن يعود قالوا ولأن هذا في زمن اشتغاله بالمعصية قد فاته فيه السير إلى الله فلو كان واقفا في موضعه لفاته التقدم فكيف وهو في زمن المعصية كان سيره إلى وراء وراء فإذا تاب واستقبل سيره فإنه يحتاج إلى سير جديد وقطع مسافة حتى يصل إلى الموضع الذي تأخر منه قالوا ونحن لا ننكر أنه قد يأتي بطاعات وأعمال تبلغه إلى منزلته وهذا مما لا يكون فإنه بالتوبة قد وجه وجهه إلى الطريق فلا يصل إلى مكانه الذي رجع منه إلا بسير مستأنف يوصله إليه ونحن لا ننكر أن العبد بعد التوبة يعمل أعمالا عظيمة لم يكن ليعملها قبل الذنب توجب له التقدم قالوا وأيضا فلو رجع إلى حاله الذي كان عليها أو إلى أرفع منها فكان بمنزلة المداوم على الطاعة أو أحسن حالا منه فكيف يكون هذا وأين مسير صاحب الطاعة في زمن اشتغال هذا بالمعصية وكيف يلتقي رجلان أحدهما سائر نحو المشرق والآخر نحو المغرب فإذا رجع أحدهما إلى طريق الآخر والآخر مجد على سيره فإنه لا يزال سابقه ما لم يعرض له فتور أو توان هذا مما لا يمكن جحده ودفعه قالوا وأيضا فمرض القلب بالذنوب على مثل مرض الجسم بالأسقام والتوبة بمنزلة شرب الدواء
والمريض إذا شرب الدواء وصح فإنه لا تعود إليه قوته قبل المرض وإن عادت فبعد حين قالوا وأيضا فهذا في زمن معالجة التوبة ملبوك في نفسه مشغول بمداواتها ومعالجتها وفي زمن الذنب مشغول بشهواتها والسالم من ذلك مشغول بربه قد قرب منه في سيره فكيف يلحقه هذا فهذا ونحوه مما احتجب به هذه الطائفة لقولها
وجرت هذه المسألة بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية فسمعته يحكي هذه الأقوال الثلاثة حكاية مجردة فإما سألته وإما سئل عن الصواب منها فقال الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله ومنهم من يعود إلى أكمل منها ومنهم من يعود إلى أنقص مما كان فإن كان بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأشد حذرا وأعظم تشميرا وأعظم ذلا وخشية وإنابة عاد إلى أرفع مما كان وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها عاد إلى أنقص مما كان عليه وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته هذا معنى كلامه
قلت وههنا مسألة هذا الموضع أخص المواضع ببيانها وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحا فهل تمحىتلك السيئات ويذهب لا له ولا عليه أو إذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديما وحديثا فقال الزجاج ليس يجعل مكان السيئة الحسنة لكن يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة قال ابن عطية يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة فيكون ذلك سببا لرحمة الله إياهم قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن ورد على من قال هو في يوم القيامة قال وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبي ذر يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات وذكره الترمذي والطبري وهذا تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية قال ابن عطية وهو معنى كرم العفو هذا آخر كلامه قلت سيأتي إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه
قال المهدوي وروي معنى هذا القول عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما وقال الثعلبي قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدلهم الله بقبيح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام فيبدلهم بالشرك إيمانا ويقتل المؤمنين قتل المشركين وبالزنا عفة وإحصانا وقال آخرون يعني يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة
وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة فمن قال إنه في الدنيا قال هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادها وهي حسنات وهذا تبديل حقيقة والذين نصروا هذا القول احتجوا بأن السيئة لا تنقلب حسنة بل غايتها أن تمحى وتكفر ويذهب أثرها فأما أن تنقلب حسنة فلا فإنها لم تكن طاعة وإنما كانت بغيضة مكروهة للرب فكيف تنقلب محبوبة مرضية قالوا وأيضا فالذي دل عليه القرآن إنما هو تكفير السيئات ومغفرة الذنوب كقوله تعالى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقوله تعالى ويعفوا عن السيئات وقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا والقرآن مملوء من ذلك وفي الصحيح من حديث قتادة عن صفوان بن محرز قال قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله يقول في النجوى قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كتفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول رب أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكفار
والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله عز و جل فهذا الحديث المتفق عليه الذي تضمن العناية بهذا العبد إنما فيه ستر ذنوبه عليه في الدنيا ومغفرتها له يوم القيامة ولم يقل له وأعطيتك بك سيئة منها حسنة فدل على أن غاية السيئات مغفرتها وتجاوز الله عنها وقد قال الله في حق الصادقين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون فهؤلاء خيار الخلق وقد أخبر عنهم أنه يكفر عنهم سيئات أعمالهم ويجزيهم بأحسن ما يعملون وأحسن ما عملوا إنما هو الحسنات لا السيئات فدل على أن الجزاء بالحسن إنما يكون على الحسنات وحدها وأما السيئات فأن تلغى ويبطل أثرها قالوا وأيضا فلو انقلبت السيئات أنفسها حسنات في حق التائب لكان أحسن حالا من الذي لم يرتكب منها شيئا وأكثر حسنات منه لأنه إذا أساء شاركه في حسناته التي فعلها وامتاز عنه بتلك السيئات ثم انقلبت له حسنات ترجح عليه وكيف يكون صاحب السيئات أرجح ممن لا سيئة له قالوا وأيضا فكما أن العبد إذا فعل حسنات ثم أتى بما يحبطها فإنها لا تنقلب سيئات يعاقب عليها بل يبطل أثرها ويكون لا له ولا عليه وتكون عقوبته عدم ترتب ثوابه عليها فهكذا من فعل سيئات ثم تاب منها فإنها لا تنقلب حسنات فإن قلتم وهكذا التائب يكون ثوابه عدم ترتب العقوبة على سيئاته لم ننازعكم في هذا وليس هذا معنى الحسنة فإن الحسنة تقتضي ثوابا وجوديا
واحتجت الطائفة الأخرى التي قالت هو تبديل السيئة بالحسنة حقيقة يوم القيامة بأن قالت حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة وهذا إنما
يكون في السيئة المحققة وهي التي قد فعلت ووقعت فإذا بدلت حسنة كان معناه أنها محيت وأثبت مكانها حسنة قالوا ولهذا قال تعالى سيئاتهم حسنات فأضاف السيئات إليهم لكونهم باشروها واكتسبوها ونكر الحسنات ولم يضفها إليهم لأنها من غير صنعهم وكسبهم بل هي مجرد فضل الله وكرمه قالوا وأيضا فالتبديل في الآية إنما هو فعل الله لا فعلهم فإنه أخبر أنه هو يبدل سيئاتهم حسنات ولو كان المراد ما ذكرتم لأضاف التبديل إليهم فإنهم هم الذين يبدلون سيئاتهم حسنات والأعمال إنما تضاف إلى فاعلها وكاسبها كما قال الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وأما ما كان من غير الفاعل فإنه يجعله من تبديله هو كما قال الله تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين فلما أخبر سبحانه أنه هو الذي يبدل سيئاتهم حسنات دل على أنه شيء فعله هو سبحانه بسيئاتهم لا أنهم فعلوه من تلقاء أنفسهم وإن كان سببه منهم وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح قالوا ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنها كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا فلقد رأيت رسول الله ضحك حتى بدت
نواجذه وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه قال فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارها فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من الكبار فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة قال فيقول إن لي ذنوبا ما أراها فلقد رأيت رسول الله ضحك حتى بدت نواجذه قالوا وأيضا فروى أبو حفص المستملي عن محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة حدثنا الفضل بن موسى القطيعي عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات قيل من هم قال الذين بدل سيئاتهم حسنات قالوا وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقة فإنهم إنما سموا أبدالا لأنهم بدلوا أعمالهم السيئة بالأعمال الحسنة فبدل الله سيئاتهم التي عملوها حسنات قالوا وأيضا فالجزاء من جنس العمل فكما بدلوا هم أعمالهم السيئة بالحسنة بدلها الله من صحف الحفظة حسنات جزاء وفاقا
قالت الطائفة الأولى كيف يمكنكم الاحتجاج بحديث أبي ذر على صحة قولكم وهو صريح في أن هذا الذي قد بدلت سيئاته حسنات قد عذب عليها في النار حتى كان آخر أهلها خروجا منها فهذا قد عوقب على
سيئاته فزال أثرها بالعقوبة فبدل مكان كل سيئة منها حسنة وهذا حكم غير ما نحن فيه فإن الكلام في التائب من السيئات لا فيمن مات مصرا عليها غير تائب فأين أحدهما من الآخر وأما حديث الإمام أحمد فهو الحديث بعينه إسنادا ومتنا إلا أنه مختصر وأما حديث أبي هريرة فلا يثبت مثله ومن أبو العنبس ومن أبوه حتى يقبل منهما تفردهما بمثل هذا الأمر الجليل وكيف يصح مثل هذا الحديث عن رسول الله مع شدة حرصه على التنفير من السيئات وتقبيح أهلها وذمهم وعيبهم والإخبار بأنها تنقص الحسنات وتضادها فكيف يصح عنه أنه يقول ليتمنين أقوام أنهم أكثروا منها ثم كيف يتمنى المرء إكثاره منها مع سوء عاقبتها وسوء مغبتها وإنما يتمنى الإكثار من الطاعات وفي الترمذي مرفوعا ليتمنين أقوام يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء فهذا فيه تمني البلاء يوم القيامة لأجل مزيد ثواب أهله وهو تمني الحسنات وأما تمني الحسنات فهذا لا ريب فيه وأما تمني السيئات فكيف يتمنى العبد أنه أكثر من السيئات هذا ما لا يكون أبدا وإنما يتمنى المسيىء أن لو لم يكن أساء وأما تمنيه أنه ازداد من إساءته فكلا قالوا وأما ما ذكرتم من أن التبديل هو إثبات الحسنة مكان
السيئة فحق وكذلك نقول إن الحسنة المفعولة صارت في مكان السيئة التي لولا الحسنة لحلت محلها قالوا وأما احتجاجكم بإضافة السيئات إليهم وذلك يقتضي أن تكون هي السيئات الواقعة وتنكير الحسنات وهو يقتضي أن تكون حسنات من فضل الله فهو حق بلا ريب ولكن من أين يبقى أن يكون فضل الله بها مقارنا لكسبهم إياها بفضله قالوا وأما قولكم إن التبديل مضاف إلى الله لا إليهم وذلك يقتضي أنه هو الذي بدلها من الصحف لا أنهم هم الذين بدلوا الأعمال بأضدادها فهذا لا دليل لكم فيه فإن الله خالق أفعال العباد فهو المبدل للسيئات حسنات خلقا وتكوينا وهم المبدلون لها فعلا وكسبا قالوا وأما احتجاجكم بأن الجزاء من جنس العمل فكما بدلوا سيئات أعمالهم بحسناتهم بدلها الله كذلك في صحف الأعمال فهذا حق وبه نقول وأنه بدلت السيئات التي كانت مهيأة ومعدة أن تحمل في الصحف بحسنات حلت موضعها
فهذا منتهى إقدام الطائفتين ومحط نظر الفريقين وإليك أيها المنصف الحكم بينهما فقد أدلى كل منهما بحجته فأقام بينته والحق لا يعدوهما ولا يتجاوزهما فأرشد الله من أعان على هدى فنال به درجة الداعين إلى الله القائمين ببيان حججه ودينه أو عذر طالبا منفردا عفي طريق مطلبه قد انقطع رجاؤه من رفيق في الطريق فغاية أمنيته أن يخلي بينه وبين سيره وأن لا يقطع عليه طريقه فمن رفع له مثل هذا العلم ولم يشمر إليه فقد رضي بالدون وحصل على صفقة المغبون ومن شمر إليه ورام أن لا يعارضه معارض ولا يتصدى له ممانع فقد منى نفسه المحال وإن صبر على لأوائهاه وشدتها فهو والله الفوز المبين والحظ الجزيل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنة والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثوابا ولهذا كان تارك المنهيات إنما يثاب على كف نفسه وحبسها عن مواقعة المنهي وذلك الكف والحبس أمر وجودي وهو متعلق
الثواب وأما من لم يخطر بباله الذنب أصلا ولم يحدث به نفسه فهذا كيف يثاب على تركه ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثابا على ترك ذنوب العالم التي لا تخطر بباله وذلك أضعاف حسناته بما لا يحصى فإن الترك مستصحب معه والمتروك لا ينحصر ولا ينضبط فهل يثاب على ذلك كله هذا مما لا يتوهم وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمرا وجوديا فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها ندما عليه وكف نفسه عنه وعزم علىترك معاودته وهذه حسنات بلا ريب وقد محت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم وهو حسنة قد بدلت تلك السيئة حسنة وهذا معنى قول بعض المفسرين يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة فإذا كانت كل سيئة من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها فهذا معنى التبديل لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة وقال بعض المفسرين في هذه الآية يعطيهم بالندم على كل سيئة أساؤوها حسنة وعلى هذا فقد زال بحمد الله الإشكال واتضح الصواب وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم والحجة وأما حديث أبي ذر وإن كان التبديل فيه في حق المصر الذي عذب على سيئاته فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للتائب المقلع النادم على سيئاته فإن الذنوب التي عذب عليها المصر لما زال أثرها بالعقوبة بقيت كأن لم تكن فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة لا يقتضي زوال أثرها وتبديلها حسنات فإن الندم لم يكن في وقت ينفعه فلما عقوب عليه وزال أثرها بدلها الله له حسنات فزوال أثرها بالتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة فإذا بدلت بعد زوالها بالعقوبة حسنات فلئن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أولى وأحرى وتأثير التوبة في هذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعا ومحبة لله وفرقا منه وأما العقوبة فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه
بغير اختياره بل بفعل الله ولا ريب أن تأثير الأفعال الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها في محو الذنوب أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره
ولنرجع الآن إلى المقصود وهو ما ذكره أبو العباس بن الصائف في علل المقامات فقد ذكرنا كلامه في علة مقام الإرادة وذكرنا أن الكلام على ذلك من وجوه هذا آخر الوجه الثاني منها
الوجه الثالث أن يقال قوله الزهد تعظيم للدنيا واحتباس عن الانتفاع بها إلى آخر الفصل إن أراد به أن زهده دليل على تعظيم الدنيا وأن لها في قلبه من القدر والمنزلة ما يكره لأجله نفسه على تركها أو مستلزم لذلك فإن الزهد لا يدل على هذا التعظيم ولا يستلزمه وإن كان من عوارض غلبات الطبع التي تذم مساكنتها وانحجاب القلب بها بل زهده فيها دليل على خروج عظمها من قلبه ومبالاته بها وترك الاهتبال بشأنها فكيف يكون هذا نقصا بوجه بل النقص في الزهد يكون من أحد وجوه
أولها أن يزهد فيما ينفعه منها ويكون قوة له على سيره ومعونة له على سفره فهذا نقص فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك والورع أن تتجنب ما قد يضرك فهذا الفرق بين الأمرين
الثاني أن يكون زهده مشوبا إما بنوع عجز أو ملالة وسآمة وتأذية بها وبأهلها وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المزهدات فيها كما قيل لبعضهم ما الذي أوجب زهدك في الدنيا قال قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها فهذا زهد ناقص فلو صفت للزاهد تلك العوارض لم يزهد فيها بخلاف من كان زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه فهذا لا نقص في زهده ولا علة من جهة كونه زهدا
الثالث أن يشهد زهده ويلحظه ولا يفنى عنه بما زهد لأجله فهذا نقص أيضا فالزهد كله أن تزهد في رؤية زهدك وتغيب عنه برؤية الفضل
ومطالعة المنة وأن لا تقف عنده فتنقطع بل أعرض عنه جادا في سيرك غير ملتفت إليه مستصغرا لحاله بالنسبة إلى مطلوبك مع أن هذه العلة مطردة في جميع المقامات على ما فيها كما سننبه عليه إن شاء الله فإن ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة الكاملة من أهم الأمور فلا يحسن بالناصح لنفسه أن يقنع فيه بمجرد تقليد أهله فما أكثر غلطهم فيه وتحكيمهم مجرد الذوق وجعل حكم ذلك الذوق كليا عاما فهذا ونحوه من مثارات الغلط
الوجه الرابع أن الزهد على أربعة أقسام أحدها فرض على كل مسلم وهو الزهد في الحرام وهذا متى أخل به انعقد سبب العقاب فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر يضاده الثاني زهد مستحب وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات المباحة الثالث زهد الداخلين في هذا الشأن وهم المشمرون في السير إلى الله وهو نوعان
أحدهما الزهد في الدنيا جملة وليس المراد تخليها من اليد ولا إخراجها وقعوده صفرا منها وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبدالعزيز الذي يضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال تحت يده بل كحال سيد ولد آدم حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح ولا يزيده ذلك إلا زهدا فيها ومن هذا الأثر المشهور وقد روي مرفوعا وموقوفا ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها
بقيت لك والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء
أحدها علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر وأنها كما قال الله تعالى فيها اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وقال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وسماها سبحانه متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها وأخبرها عن سوء عاقبة المغترين وحذرنا مثل مصارعهم وذم من رضي بها واطمأن إليها وقال النبي ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها وفي المسند عنه حديث معناه أن الله
جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا فإنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية وعقل حقير وقدر خسيس
الثاني علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا وهي دار البقاء وأن نسبتها إليها كما قال النبي ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل قيل له اطرحه فلك عوضه مائة ألف دينار مثلا فألقاه من يده رجاء ذلك العوض فالزهد فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها زهد فيها
الثالث معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها فمتى تيقن ذلك وصار له به علم يقين هان عليه الزهد فيها فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا والعاقل لا يرضى لنفسه
بذلك فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثبت قدمه في مقامه والله الموفق لمن يشاء
النوع الثاني الزهد في نفسك وهو أصعب الأقسام وأشقها وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم يلجوه فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام لسوء مغبته وقبح ثمرته وحماية لدينه وصيانة لإيمانه وإيثارا للذة والنعيم على العذاب وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة وحمية من أن يستأثر لعدوه ويسهل عليه الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمه بما يفوته بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم ويسهل عليه زهده في الدنيا معرفته بما وراءها وما يطلبه من العوض التام والمطلب الأعلى وأما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين وهو نوعان أحدهما وسيلة وبداية وهو أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها قد سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها فهي أهون عليك من أن تنتصر لها أو تنتقم لها أو تجيبها إذا دعتك أو تكرمها إذا عصتك أو تغضب لها إذا ذمت بل هي عندك أخس مما قيل فيها أو ترفهها عما فيه حظك وفلاحك وإن كان صعبا عليها وهذا وإن كان ذبحا لها وإماتة عن طباعها وأخلاقها فهو عين حياتها وصحتها ولا حياة لها بدون هذا البتة وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها على منازل المقربين ويننحدر منها إلى وادي البقاء ويشرب من عين الحياة ويخلص روحه من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها الحق فيا قرة عينها به ويا نعيمها وسرورها بقربه ويا بهجتها بالخلاص من عدوها واللجوء إلى مولاها ومالك أمرها ومتولي مصالحها وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب فيا مفلس تأخر والنوع الثاني غاية وكمال وهو أن يبذلها للمحبوب جملة بحيث لا يستبقي منها شيئا بل يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة محبوبه به فهل يجد من قلبه رغبة في
إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه فهو يبذلها له دائما بتعرض منه لقبولها وجميع مراتب الزهد المتقدمة مباد ووسائل لهذه المرتبة ولكن لا يصح إلا بتلك المراتب فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فمتعن متمن كمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سلم قال بعض السلف إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول فمن ضيع الأصول حرم الوصول وإذا عرف هذا فكيف يدعي أن الزهد من منازل العوام وأنه نقص في طريق الخاصة وهل الكمال إلا في الزهد وما النقص إلا في نقصانه والله الموفق للصواب فصل المثال الرابع التوكل قال أبو العباس هو للعوام أيضا لأنه وكل أمرك إلى مولاك والتجاؤك إلى علمه ومعرفته لتدبير أمرك وكفاية همك وهذا في طريق الخواص عمى عن الكفاية به ورجوع إلى الأسباب لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل فصار بدلا عن تلك الأسباب فإنك معلق بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلب من علة التوكل وهو أن يعلم أن الله لم يترك أمرا مهملا بل فرغ من الأشياء وقدرها وإن اختلف منها شيء في المعقول أو تشوش في المحسوس أو اضطراب في المعهود فهو المدبر له وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت والمتوكل من أراح نفسه من كل النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده وهو أن يعلم أن الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الله كفاه الله كل
مهم ثم ذكر حكاية عن موسى أنه في رعايته نام عن غنمه فاستيقظ فوجد الذئب واضعا عصاه على عاتقه يرعاها فعجب من ذلك فأوحىالله إليه يا موسى كن لي كما أريد أكن لك كما تريد
فيقال الكلام على هذا من وجوه
أحدها إن جعله التوكل من منازل العوام باطل كما تقدم بل الخاصة أحوج إليه من العامة وتوكل الخواص أعظم من توكل العوام والتوكل مصاحب للصادق من أول قدم يضعه في الطريق إلى نهايته وكلما ازداد قربه وقوي سيره ازداد توكله فالتوكل مركب السائر الذي لا يتأتى له السير إلا به ومتى نزل عنه انقطع لوقته وهو من لوازم الإيمان ومقتضياته قال الله تعالى وعلىالله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فجعل التوكل شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل وفي الآية الأخرى وقال موسى يا قوم إن كنتم ءامنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فجعل دليل صحة الإسلام التوكل وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون فذكر اسم الإيمان ههنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان وبين التوكل والإسلام وبين التوكل والتقوى وبين التوكل والهداية فأما التوكل والعبادة فقد جمع بينهما في سبعة مواضع من كتابه أحدهما في سورة أم
القرآن فقال إياك نعبد وإياك نستعين والثاني قوله حكاية عن شعيب أنه قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الثالث قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنهم قالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الرابع قوله تعالى لنبيه محمد واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الخامس قوله ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون السادس قوله فأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير السابع قوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب فهذه السبعة المواضع جمعت الأصلين التوكل وهو الوسيلة والإنابة وهي الغاية فإن العبد لا بد له من غاية مطلوبه ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه والإنابة إليه وأعظم وسائله التي لا وسيلة لها غيرها البتة التوكل على الله والاستعانة به ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة فهذه أشرف الغايات وتلك أشرف الوسائل وأما الجمع بين الإيمان والتوكل ففي مثل قوله تعالى قل هو الرحمن إمنا به وعليه توكلنا ونظيره قوله وعلى الله فتوكلوا
إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وأما الجمع بين التوكل والإسلام ففي قوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم ءامنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وأما الجمع بين التقوى والتوكل ففي مثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى قوله تعالى وتوكل على الله وكفىبالله وكيلا وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي مثل قول الرسل لقومهم ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقال الله تعالى لنبيه فتوكل على الله إنك على الحق المبين فأمر سبحانه بالتوكل عليه وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح له مستدع لثبوته وتحققه وهو قوله تعالى إنك على الحق المبين فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد فإن الله هو الحق وهو ولي الحق وناصره ومؤيده وكافي من قام به فما لصاحب الحق أن لا يتوكل عليه وكيف يخاف وهو على الحق كما قالت الرسل لقومهم ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم وأخبروا أن ذلك
لا يكون أبدا وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان فصاحب الحق لعلمه بالحق ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره مضطر إلى توكله علىالله لا يجد بدا من توكله فإن التوكل يجمع أصلين علم القلب وعمله أما علمه فيقينه بكفايةوكيله وكمال قيامه بما وكله إليه وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك وأما عمله فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه فبهذين الأصلين يتحقق التوكل وهما جماعه وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من عمله كما قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب ولكن لا بد فيه من العلم وهو إما شرط فيه وإما جزاء من ماهيته والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن الله وليه وناصره وسكونه إليه فما له أن لا يتوكل على ربه وإذا كان على الباطل علما وعملا أو إحداهما لم يكن مطمئنا واثقا بربه فإنه لا ضمان له عليه ولا عهد له عنده فإن الله لا يتولى الباطل ولا ينصره ولا ينسب إليه بوجه فهو منقطع النسب إليه بالكلية فإنه سبحانه هو الموفق وقوله الحق ودينه الحق ووعده حق ولقاؤه حق وفعله حق ليس في أفعاله شيء باطل بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطل كما أقواله كذلك فلما كان الباطل لا يتعلق به بل هو مقطوع البتة كان صاحبه كذلك ومن لم يكن له تعلق بالله العظيم وكان منقطعا عن ربه لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة أن تودع في خزانة القلب لشدة الحاجة إليها والله السمتعان عليه وعليه التكلان فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل والله أعلم
الوجه الثاني أن قوله في التوكل إنه في طريق الخواص عمى عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب إلخ مضمونه أن التوكل لا يتم إلا برفض الأسباب والإعراض عنها جملة والتوكل من أقوى الأسباب وأعظمها في حصول المطلوب فكأنه قد رفض سببا وتعلق بسبب وقد ناقض في أمره ولهذا قال فصار بدلا عن تلك الأسباب وكأنك تعلقت بما رفضته فهذه هي النكتة التي لأجلها صار التوكل عنده من منازل العوام وهذه هي غير مسألة الجمع بين التوكل والسبب بل هذه مسألة تعليل نفس التوكل فيقال قولك إنه عمى عن الكفاية ليس كذلك بل هو نظر إلى نفس الكفاية وملاحظة لها ولا ريب أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها من عبوديته وسببها المقتضي لها هو التوكل كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه فجعل التوكل سببا للكفاية فربط الكفاية بالتوكل كربط سائر الأسباب بمسبباتها فكيف يقال إن التوكل عمى عن الكفاية وهل التوكل إلا محض العبودية التي جزاؤها الكفاية وهي لا تحصل بدونه بل العلة ههنا شهود حصولها بفعلك وتوكلك غير ناظر إلى مسبب الأسباب الذي أجرى عليك هذا السبب ليوصلك به إلى الكفاية فأول الأمر وآخره منه فهو المنعم بالسبب والمسبب جميعا ولكن لا يوجب نظر العبد إلى المسبب المنعم بالسبب قطع نظره عن السبب والقيام به بل الواجب القيام بالأمرين معا
الوجه الثالث أن قوله إنه رجوع إلى الأسباب إن أراد به أنه رجوع إلى سبب ينقص العبودية ويضعف التوكل فليس كذلك وظاهر أن الأمر ليس كذلك وإن أراد به أنه رجوع إلى سبب نصبه الله مقتضيا للكفاية منه ورتب عليه جزاء لا يحصل بدونه فهذا حق ولكن القيام بهذا السبب
محض الكمال ونفس العبودية وهو كجعل الإسلام والإيمان والإحسان أسباب مقتضية للفلاح والسعادة بل كجعل سائر أعمال القلوب والجوارح أسبابا مقتضية لما رتب عليها من الجزاء وهل الكمال إلا القيام بهذه الأسباب فالأسباب التي تكون مباشرتها نقصا هي الأسباب التي تضعف التوكل وأما أن يكون التوكل نفسه ناقصا لكون التحقق به تحققا بالسبب فقلب للحقائق
الوجه الرابع أن قوله لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل إن أراد به رفض الأسباب جملة فهذا كما أنه ممتنع عقلا وحسا فهو محرم شرعا ودينا فإن رفض الأسباب بالكليةانسلاخ من العقل والدين وإن أراد به رفض الوقوف معها والوثوق بها وأنه يقوم قيام ناظر إلى سببها فهذا حق ولكن النقص لا يكون في السبب ولا في القيام به وإنما يكون في الإعراض عن المسبب تعالى كما تقدم فمنع الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل والشرع وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها قدح في التوحيد والتوكل والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها وتعلق القيام به جمع بين الأمر والتوحيد وبين الشرع والقدر وهو الكمال والله أعلم
الوجه الخامس قوله فصار التوكل بدلا عن تلك الأسباب هذا حق فإن التوكل من أعظم الأسباب ولكنه بدل عنها كما تكون الطاعة بدلا عن المعصية والتوحيد بدلا عن الشرك فهو بدل واجب مأمور به مطلوب من العبد والمذوم أن يجعل العبد الأسباب بدلا عن التوكل لا أن يجعل التوكل بدلا عن الأسباب
الوجه السادس قوله فكأنك تعلقت بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال ليس كذلك فإن المرفوض هو التعلق بغير الله والالتفات إلى سواه فهذا هو الذي رفضه وأما الذي تعلق به فهو التوكل على الله واللجأ
إليه والتفويض إليه والاستعانة به فقد رفض المخلوق وتعلق بالخالق فكيف يقال إنه تعلق بما رفضه
الوجه السابع أن قوله من حيث معتقدك الانفصال يشير به إلى أن التوكل نوع تفرقة وانفصال يشهد فيه مع الله غيره وهذا مناف للفناء في التوحيد وأن لا يشهد مع الله غيره أصلا وهذا قطب رحى السير الذي يشير إليه القوم والعلم الذي يشمرون إليه ولأجله يجعلون كل ما دونه من المقامات معلولا ولا بد من فصل القول فيه بعون الله وتأييده فإنه نهاية إقدامهم وغاية مرماهم فنقول وبالله التوفيق
الفناء الذي يشار إليه على ألسنة السالكين ثلاثة أقسام فناء عن وجود السوي وفناء عن شهود السوي وفناء عن عبادة السوي وإرادته وليس هنا قسم رابع
فأما القسم الأول فهو فناء القائلين بوحدة الوجود فهو فناء باطل في نفسه مستلزم جحد الصانع وإنكار ربوبيته وخلقه وشرعه وهو غاية الإلحاد والزندقة وهذا هو الذي يشير إليه علماء الاتحادية ويسمونه التحقيق وغاية أحدهم فيه أن لا يشهد ربا وعبدا وخالقا ومخلوقا وآمرا ومأمورا وطاعة ومعصية بل الأمر كله واحد فيكون السالك عندهم في بدايته يشهد طاعة ومعصية ثم يرتفع عن هذا الفرق بكشف عندهم إلى أن يشهد الأفعال كلها طاعة لله لا معصية فيها وهو شهود الحكم والقدر فيشهدها طاعة لموافقتها الحكم والمشيئة وهذا ناقص عندهم أيضا إذ هو متضمن للفرق ثم يرتفع عندهم عن هذا الشهود إلى أن لا يشهد لا طاعة ولا معصية إذ الطاعة والمعصية إنما تكون من غير لغير وما ثم غير فإذا تحقق بشهود ذلك وفني فيه فقد فني عن وجود السوي فهذا هو غاية التحقيق عندهم ومن لم يصل إليه فهو محجوب ومن أشعارهم في هذا قول قائلهم
وما أنت غير الكون بل أنت عينه ... ويفهم هذا السر من هو ذائق
وقول الآخر
ما الأمر إلا نسق واحد ... ما فيه من مدح ولا ذم
وإنما العادة قد خصصت ... والطبع والشارع بالحكم
وقول الآخر
وما الموج إلا البحر لا شيء غيره ... وإن فرقته كثرة المتعدد
والقسم الثاني من أقسام الفناء هو الذي يشير إليه المتأخرون من أرباب السلوك وهو الفناء عن شهود السوي مع تفريقهم بين الرب والعبد وبين الطاعة والمعصية وجعلهم وجود الخالق غير وجود المخلوق ثم هم مختلفون في هذا الفناء على قولين أحدهما أنه الغاية المطلوبة من السلوك وما دونه بالنسبة إليه ناقص ومن هنا يجعلون المقامات والمنازل معلولة والقول الثاني أنه من لوازم الطريق لا بد منه للسالك ولكن البقاء أكمل منه وهؤلاء يجعلونه ناقصا ولكن لا بد منه وهذه طريقة كثيرة من المتقدمين وهؤلاء يقولون إن الكمال شهود العبودية مع شهود المعبود فلا يغيب بعبادته عن معبوده ولا بمعبوده عن عبادته ولكن لقوة الوارد وضعف المحل وغلبة استيلاء الوارد على القلب حتى يملكه من جميع جهاته يقع الفناء والتحقيق أن هذا الفناء ليس بغاية ولا من لوازم الطريق بل هو عارض من عوارض الطريق يعرض لبعض السالكين دون جميعهم وسببه أمور ثلاثة
أحدها قصده وإرادته والعمل عليه فإنه إذا علم أنه الغاية المطلوبة شمر سائرا إليه عاملا عليه فإذا أشرف عليه وقف معه ونزل بواديه وطلب مساكنته فهؤلاء إنما يحصل لهم الفناء لأن سيرهم كان طلب حظهم ومرادهم من الله وهو الفناء لم يكن سيرهم علىتحصيل مراد الله منهم وهو القيام بعبوديته والتحقق بها والسائر على طلب تحصيل مراد الله منه لا يكاد الفناء يحل بساحته ولا يعتريه السبب الثاني قوة الوارد
بحيث يغمره ويستولي عليه فلا يبقى فيه متسع لغيره أصلا السبب الثالث ضعف المحل عن احتمال ما يرد عليه فمن هذه الأسباب الثلاثة يعرض الفناء ولما رأى الصادق في طريقه السالك إلى ربه أكثر أصحاب الفرق محجوبون على هذا المقام مشتتون في أودية الفرق وشهدوا نقصهم ورأوا ما هم فيه من الفناء أكمل ظنوا أنه لا كمال وراء ذلك وأنه الغاية المطلوبة فمن هنا جعلوه غاية
ولكن أكمل من ذلك وأعلى وهو الفناء عن عبادة السوي وإرادته وخشيته ورجائه والتوكل عليه والسكون إليه فيفنى بعبادة ربه ومحبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه وبالسكون إليه عن عبادة غيره وعن محبته ورجائه والتوكل عليه مع شهود الغير ومعاينته فهذا أكمل من فنائه عن عبودية الغير ومحبته مع عدم شهوده له وغيبته عنه فإذا شهد الغير في مرتبته أوجب شهوده له زيادة في محبة معبوده وتعظيما له وهروبا إليه وضنا به فإن نظر المحب إلى مبادي محبوبه ومضاده يوجب زيادة حبه له وفي هذا المعنى قال القائل
وإذا نظرت إلى أمري زادني ... حبا له نظري إلى الأمراء
وكان النبي يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت / ح / وفي سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت / ح / وكذلك في ركوعه اللهم
لك ركعت وبك آمنت / ح / فهذا دعاء من قد جمع بين شهود عبوديته وشهود معبوده ولم يغب بأحدهما عن الآخر وهل هذا إلا كمال العبودية أن يشهد ما يأتي به من العبودية موجها لها إلى المعبود الحق محضرا لها بين يديه متقربا بها إليه فأما الغيبة عنها بالكلية بحيث تبقى الحركات كأنها طبيعية غير واقعة بالإرادة فهذا وإن كان أكمل من حال الغائب بشهود عبوديته عن معبوده فحال الجامع بين شهود العبودية والمعبود أكمل منهما وإذا عرفت هذه القاعدة ظهر إن تعليله التوكل بما ذكر تعليل باطل
الوجه الثامن أن التوكل على الله نوعان أحدهما توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرهما والثاني توكل عليه في تحصيل مرضاته فأما النوع الأول فغايته المطلوبة وإن لم تكن عبادة لأنها محض حظ العبد فالتوكل على الله في حصوله عبادة فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه وأما النوع الثاني فغايته عباده وهو في نفسه عبادة فلا علة فيه بوجه فإنه استعانة بالله على ما يرضيه فصاحبه متحقق بإياك نعبد وإياك نستعين فتركه ترك لشطر الإيمان والعلة إنما هي في ضعف هذا التوكل فهب أن التوكل في حصول الحظ معلول فيلزم من هذا أن يكون التوكل في حصول مراد الرب سبحانه ومرضاته معلولا
الوجه التاسع قوله وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلوب من علة التوكل فيقال إذا كان هذا التوكل عندك ليس بمعلول ولا هو عمى عن الكافية ولا رجوع إلى الأسباب بعد رفضها بطل تعليل التوكل بما عللته به وإن كانت هذه العلة بعينها موجودة في هذا التوكل
بطل أن يكون علة فلزم بطلان كونه معلولا على التقديرين وظهر أن العلة في التوكل لا تخرج عن أحد شيئين إما أن يكون متعلقه حظا من حظوظك وإما وقوفك معه وركونك إليه فقط فإذا خلص التوكل من هذا وهذا فلا علة تلحقه ولا نقيصة تدركه
الوجه العاشر أن علة التوكل عنده هي ترك التوكل كما فسره فكيف يتوكل في ترك التوكل وهل هذا إلا جمع بين متضادين
الوجه الحادي عشر قوله وهو أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمرا مهملا بل فرغ من الأشياء وقدرها وإن اختلف منها شيء في العقول أو تشوش في المحسوس أو اضطرب في المعهود فهو المدبر له وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت المتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده إلى آخر كلامه فيقال هو سبحانه فرغ من الأشياء وقدرها بأسبابها المفضية إليها فكما أن المسببات من قدره الذي فرغ منه فأسبابها أيضا من قدره الذي فرغ منه فتقديره المقادير بأسبابها لا ينافي القيام بتلك الأسباب بل يتوقف حصولها عليها وقد سئل النبي فقيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقي نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله / ح / وسئل أعلم أهل الجنة والنار فقال
نعم فقالوا ففيم العمل قالوا اعملوا فكل مسير لما خلق له فأمرهم بالأعمال وأخبرهم أن الله يسر كل عبد لما خلق له فجعل عمله سببا لنيل ما خلق له من الثواب والعقاب فلا بد من إثبات السبب والمسبب جميعا
الوجه الثاني عشر قوله المتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده فهذا الكلام إن أخذ على إطلاقه فهو باطل قطعا فإن السكون إلى ما سبق من القسمة وترك السبب في أعمال البر عين العجز وتعطيل الأمر والشرع ولا يجوز شرعا ولا عقلا التسوية بين الحالين وأما السكون إلى ما سبق من القسمة في أسباب المعيشة فهو حق ولكن الكمال أن يكون ساكنا إلى ما سبق مع قيامه وهذه حالة الكملة من الصحابة ومن بعدهم فالكمال هو تنزيل الأسباب منازلها علما وعملا لا الإعراض عنها ومحوها ولا الانتهاء إليها والوقوف عندها
الوجه الثالث عشر قوله مع استواء الحالين عنده وهو أن يعلم أن الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع يشير به إلى استواء الحالين في مباشرة السبب وتركه نظرا إلى ما سبق وهذا ليس بمأمور ولا معذور فإنه لا تستوي الحالتان شرعا ولا قدرا وكيف يستوي مالم يسوه الله شرعا ولا قدرا
الوجه الرابع عشر قوله الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع فقد بين أن التوكل لا ينافي الطلب بل حقيقة التوكل وكماله مقارنته للطلب ومصاحبته للسبب وأما توكل مجرد عن الطلب والسبب فعجرز وأماني فتوكل الحراث إنما هو بعد شق الأرض وبذرها وحينئذ يصح منه التوكل في طلوع الزرع وأما توكله من غير حرث ولا بذر فعجز وبطالة
الوجه الخامس عشر قوله ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الله كفاه كل مهم فيقال التوكل يكون في أحد شيئين إما في حصول حظ العبد ورزقه ونصره وعافيته وإما في حصول مراد ربه منه وكلاهما عبادة مأمور بها والثاني أكمل من الأول بحسب المتوكل فيه ولكن توكله في الأول لا يكون معلولا من حيث هو توكل وإنما تكون علته أن صرف توكله إلى غيره أولى بالتوكل منه وهذا إنما يكون نقصا إذا ضعف توكله في الأمر ومراد الله منه وأما إن لم يضعفه بل أعطى كل مقام حقه من التوكل فهذا محض العبودية والله أعلم فصل المثال الخامس الصبر قال أبو العباس وهو من منازل العوام أيضا لأن الصبر حبس النفس على مكروه وعقل اللسان عن الشكوى ومكابدة الغصص في تحمله وانتظار الفرج عن عاقبته وهذا في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة ومنازعة فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى وتحقيقه الخروج عن الشكوى بالتذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى وقيل إنه على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض فالأول التصبر وهو تحمل مشقة وتجرع غصة
والثبات على ما يجري من الحكم وهذا هو التصبر لله وهو صبر العوام والثاني الصبر وهو نوع سهولة تخفف عن المبتلي بعض الثقل وتسهل عليه صعوبة المراد وهو الصبر لله وهو نوع سهولة وهو صبر المريدين والثالث الاصطبار وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين والكلام على هذا من وجوه
أحدها أن يقال الصبر نصف الدين فإن الإيمان نصفان رد نصف صبر ونصف شكر قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال النبي والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن فمنازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر والذي يوضح هذا
الوجه الثاني وهو أن العبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر وأما الشكر فهو قيدها وثباتها والكفيل بمزيدها وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبها وعلى القيام بالأسباب التي تحفظها فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلى ومن هنا يعلم سر مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر وأن كلا منهما محتاج إلى الشكر والصبر وأنه قد يكون صبر الغني أكمل من صبر الفقير كما قد يكون شكر الفقير أكمل فأفضلهما أعظمهما شكرا وصبرا فإن فضل أحدهما في ذلك فضل صاحبه فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر
أيضا أما الصبر فظاهر وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية فإن لله على العبد أن يقوم بعبوديته في هذا وهذا فعلم أنه لا انفكاك له عن الصبر ما دام سائرا إلى الله
الوجه الثالث أن الصبر ثلاثةأقسام إما صبر عن المعصية فلا يرتكبها وإما صبر على الطاعة حتى يؤديها وإما صبر على البلية فلا يشكو ربه فيها وإن كان العبد لا بد له من واحد من هذه الثلاثة فالصبر لازم له أبدا لا خروج له عنه البتة
الوجه الرابع أن الله سبحانه ذكر الصبر في كتابه في نحو تسعين موضعا فمرة أمر به ومرة أثنى على أهله ومرة أمر نبيه أن يبشر به أهله ومرة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية ومرة أخبر أنه مع أهله وأثنى به على صفوته من العالمين وهم أنبياؤه ورسله فقال عن نبيه أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وقال لخاتم أنبيائه ورسله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال واصبر وما صبرك إلا بالله وقال يوسف الصديق وقد قال له إخوته إءنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وهذا يدل على أن الصبر من أجل مقامات الإيمان وأن أخص الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياما وتحققا به وأن الخاصة أحوج إليه من العامة
الوجه الخامس أن الصبر سبب في حصول كل كمال فأكمل الخلق أصبرهم ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص فإذا انضم الثبات إلى
العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل ولهذا في دعاء النبي الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر فلو علم العبد الكنز الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة أعني اسم الصبر لما تخلف عنه قال النبي ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وقال عمر بن الخطاب حين غشي عليه أدركناه بالصبر وفي مثل هذا قال قائل
نزه فؤادك عن سوانا والقنا ... فجنابنا حل لكل منزه
والصبر طلسم لكنز وصالنا ... من حل ذا الطلسم فاز بكنزه
فالصبر طلسم على كنز السعادة من حله ظفر بالكنز
الوجه السادس قوله الصبر حبس النفس على مكروه وعقل اللسان عن الشكوى ومكابدة الغصص في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته فيقال هذا أحد أقسام الصبر وهو الصبر على البلاء وأما الصبر على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه وقد لا يعرض فيه بل يتحلى
بها ويأتي بها محبة ورضى ومع هذا فالصبر واقع عليها فإنه حبس النفس على مداومتها والقيام بها قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي وأما الصبر عن المعصية فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه وقد لا يعرض فيه لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبته وإذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إنما يعرض في الصبر على البلية فقوله إنه في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة ومنازعة ليس كذلك وإنما فيه التجلد فأين المناوأة والجرأة والمنازعة وأما لوازم الطبيعة من وجود ألم البلوى فلا تنقلب ولا تعدم فلا يصح أن يقال إن وجود التألم والتجلد عليه وحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى جرأة ومنازعة بل هو محض العبودية والاستكانة وامتثال الأمر وهو من عبودية الله المفروضة على عبده في البلاء فالقيام بها عين كمال العبد ولوازم الطبيعة لا بد منها ومن رام أن لا يجد البرد والحر والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعللها فقد رام الممتنع وهل يكون الأجر إلا على وجود تلك الآلام والمشاق والصبر عليها وقد ثبت عن النبي أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وقيل له في مرضه إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل إن
لي أجر رجلين منكم يعني في وعكة ولا ريب أن ذلك الوعك مؤلم له وأيضا في مرض موته قال وارأساه وهذا إنما هو من وجود ألم الصداع وكان يقول في غمرات الموت اللهم أعني على سكرات الموت وهذا كله لتكميل أجره وزيادة رفعة درجاته وهل كان ذلك
إلا محض العبودية وعين الكمال وهل الجرأة والمناوأة والمنازعة إلا في ترك الصبر وفي التسخط والشكوى
الوجه السابع قوله فإن حامله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحامل الأذى بالبلوى والاستبشار باختيار المولى فيقال الذي يمكن الخروج عنه هو الشكوى وأما أن يخرج عن ذوق البلوى فلا يجده أو يتلذذ به فهذا غير ممكن ولا هو في الطبيعة وإنما الممكن أن يشاهد العبد في تضاعيف البلاء لطف صنع الله به وحسن اختياره له وبره به في حمله عنه مؤنة حمله وتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به وبره وحسن اختياره عن شهود حمله فيحصل له لذة بما شهده من ذلك وفوق هذا مرتبة أرفع منه وهي أن يشهد أن هذا مراد محبوبه وأنه بمرأى منه ومسمع وأنه هديته إلى عبده وخلعته التي خلعها عليه ليرفل له في أذيال التذلل والمسكنة والتضرع لعزته وجلاله فيعلم العبد أن حقيقة المحبة هي موافقة المحبوب في محابه فيحب ما يحبه محبوبه فيحب العبد تلك الحال من حيث موافقته لمحبوبه وإن كرهها من حيث الطبع البشري فإن هذه الكراهة لا تنافي محبته لها كما يكره طبعه الداء الكريه وهو يحبه من وجه آخر وهذا لا ينكر في المحبة المتعلقة بالمخلوق مع ضعفها وضعف أسبابها كما قال القائل في ذلك
أهوى هواه وبعدي عنه يعجبه ... فالبعد قد صار لي في حبه أربا
وقال الآخر
وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ... ما من يهون عليك ممن أكرم
وإنه لتبلغ المحبة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه عن مراده هو منه فإذا شهد مراد محبوبه أحبه وإن كان كريها إليه فهذا لا ينكر ولا ينافي التألم بمراد المحبوب المنافي للمحب وصبره عليه بل يجتمع في حقه الأمران وتقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى
وإفضائها إلى غاية النعيم واللذة فكلما قوي علمه بذلك وقويت محبته لمن ذكره بابتلائه ازداد تلذذه بها مع الكراهية الطبيعية التي هي من لوازم الخلقة ولا سيما إذا علم المحب الذي أحب الأشياء إليه أن يجري ذكره على بال محبوبه أن محبوبه قد ذكره بنوع من الامتحان فإنه يفرح بذكره له وإن ساءه ما ذكره به كما قال القائل
لئن ساءني أن نلتني بمساءة ... لقد سرني أني خطرت ببالكا
الوجه الثامن قوله وهو على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض فالأول التصبر إلى قوله وهو صبر العوام فيقال لا ريب أن التصبر مؤذن بتكلف وتحمل على كره ولكن هذا لا بد منه في الصبر وهو سببه الذي ينال به فالتصبر من العبد والصبر ثمرته التي يفرعها الله إذا تعاطاه وتكلفه كما قال النبي ومن يتصبر يصبره الله فمنزلة التصبر من الصبر منزلة التعلم والتفهم من العمل والفهم فلا بد منه في حصول الصبر
الوجه التاسع قوله والثاني الصبر وهو نوع سهولة يخفف عن المبتلى بعض الثقل ويسهل عليه صعوبة المراد وهو الصبر لله وهو صبر المريدين فقد تقدم أن الصبر ثمرة التصبر وكلاهما إنما يحمد إذا كان لله وإنما يكون إذا كان بالله فما لم يكن به لا يكون وما لم يكن له لا ينفع ولا يثمر فكلاهما لا يحصل للمريد السالك مقصوده إلا أن يكون بالله ولله قال تعالى في الصبر به واصبر وما صبرك إلا بالله وقال في الصبر له واصبر لحكم ربك واختلف الناس أي الصبرين أعلى وأفضل
الصبر له أو به فقالت طائفة منهم صاحب منازل السائرين وأضعف الصبر الصبر لله وهو صبر العامة وفوقه الصبر بالله وهو صبر العابد الذي تصبر نفسه لأمر الله طالبا لمرضاته وثوابه فهو صابر على العمل صابر عن المحرمات وأما الصبر به فهو تبرؤ من الحول والقوة وإضافة ذلك إلى الله وهو صبر المريد وأما الصبر على الله فصبر السالك على ما يجيء به متعلق أقداره وأحكامه والصواب أن الصبر لله أكمل من لاصبر به فإن الصبر له متعلق بإلهيته ومحبته والصبر به متعلق بربوبيته ومشيئته وما هو له أكمل مما هو به فإن ما هو له هو الغاية وما هو به هو الوسيلة فالصبر به وسيلة والصبر له غاية وبينهما من التفاوت ما بين الغايات والوسائل وأيضا فإن الصبر له متعلق بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وهاتان الكلمتان منقسمتان بين العبد وبين الله كما ثبت عن النبي فيما يروي عن ربه و إياك نعبد وهي التي لله وإياك نستعين هي التي للعبد وما لله أكمل مما للعبد فما تعلق بما هو له أفضل مما تعلق بما
هو للعبد وأيضا فالصبر له مصدره المحبة والصبر به مصدره الاستعانة والمحبةأكمل من الاستعانة وأما الصبر على الله فهو الصبر على أحكامه الدينية والكونية فهو يرجع إلى الصبر على أوامره والصبر على ابتلائه فليس في الحقيقة قسما ثالثا والله أعلم فقد تبين أن الصبر بجميع أقسامه أصل مقامات الإيمان وهو أصل لكمال العبد الذي لا كمال له بدونه ولا يذم منه إلا قسم واحد وهو الصبر عن الله فإنه صبر المعرضين المحجوبين فالصبر عن المحبوب أقبح شيء وأسوؤه وهو الذي يسقط المحب من عين محبوبه فإن المحب كلما كان أكمل محبة كان صبره عن محبوبه متعذرا
الوجه العاشر قوله الثالث الاصطبار وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين فيقال الاصطبار افتعال من الصبر كالاكتساب والاتخاذ وهو مشعر بزيادة المعنى على الصبر كأنه صار سجية وملكة فإن هذا البناء مؤذن بالاتخاذ والاكتساب قال تعالى فارتقبهم واصطبر فالاصطبار أبلغ من الصبر كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب ولهذا كان في العمل الذي يكون على صاحبه والكسب فيما له قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت تنبيها على أن الثواب يحصل لها بأدنى سعي وكسب وأن العقاب إنما هو باكتسابها وتصرفها وما تعانيه وإذا علم العقاب إنما هو باكتسابها وتصرفها وما تعانيه وإذا علم هذا فالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار الله سبحانه لا يخص الاصطبار بل يكون مع الصبر ومع التصبر ولكن لما كان الاصطبار أبلغ من الصبر وأقوى كان بهذا التلذذ والاستبشار أولى والله أعلم
قاعدة الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة
أحدها علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب
السبب الثاني الحياء من الله سبحانه فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه بمرأى منه ومسمع وكان حييا استحيى من ربه أن يتعرض لمساخطه
السبب الثالث مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمةمن الله بحسب ذلك الذنب فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلها وإن أصر لم ترجع إليه ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة حتى تسلب النعم كلها قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأعظم النعم الإيمان وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة يزيلها ويسلبها وقال بعض السلف أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة وقال آخر أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن وفي مثل هذا قيل
إذا كنت في نعمة فارعها ... فإن المعاصي تزيل النعم
وبالجملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب عياذا بالله من زوال نعمته وتحويل عافيته
السبب الرابع خوف الله وخشية عقابه وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله وهذا السبب يقوى بالعلم
واليقين ويضعف بضعفهما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال بعض السلف كفى بخشية الله علما والاغترار بالله جهلا
السبب الخامس محبة الله وهي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه فإن المحب لمن يحب مطيع وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها وفرق بين من يحمله علىترك معصية سيده خوفه من سوطه وعقوبته وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده وفي هذا قال عمر نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من معصيته فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه وههنا لطيفة يجب التنبه لها وهي أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر ما لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه فإذا قارنها بالإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة وإلا فالمحبة الخالية عنهما إنما توجب نوع أنس وانبساط وتذكر واشتياق ولهذا يتخلف عنها أثرها وموجبها ويفتش العبد قلبه فيرى نوع محبة لله ولكن لا تحمله على ترك معاصيه وسبب ذلك تجردها عن الإجلال والتعظيم فما عمر القلب شيء كالمحبةالمقترنة بإجلال الله وتعظيمه وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
السبب السادس شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع من قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة
السبب السابع قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشيء منها من سواد الوجه وظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه وتمزق شمله وضعفه عن مقاومة عدوه وتعريه من زينته والحيرة في أمره وتخلي وليه وناصره عنه وتولي عدوه المبين له وتواري العلم الذي كان مستعدا له عنه ونسيان ما كان حاصلا له أو ضعفه ولا بد ومرضه الذي إذا استحكم به فهو الموت ولا بد فإن الذنوب تميت القلوب ومنها ذله بعد عزه ومنها أنه يصير أسيرا في يد أعدائه بعد أن كان ملكا متصرفا يخافه أعداؤه ومنها أنه يضعف تأثيره فلا يبقى له نفوذ في رعيته ولا في الخارج فلا رعيته تطيعه إذا أمرها ولا ينفذ في غيرهم ومنها زوال أمنه وتبدله به مخافة فأخوف الناس أشدهم إساءة ومنها زوال الأنس والاستبدال به وحشة وكلما ازداد إساءة ازداد وحشة ومنها زوال الرضى واستبداله بالسخط ومنها زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإيواء عنده واستبداله بالطرد والبعد منه ومنها وقوعه في بئر الحسرات فلا يزال في حسرة دائمة كلما نال لذة نازعته نفسه إلى نظيرها إن لم يقض منها وطرا أو إلى غيرها إن قضى وطره منها وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه وكلما اشتد نزوعه وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه فيا لها نارا قد عذب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ومنها فقره بعد غناه فإنه كان غنيا بما معه من رأس مال الإيمان وهو يتجر به ويربح الأرباح الكثيرة فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيرا معدما فإما أن يسعى بتحصيل رأس مال آخر بالتوبة النصوح والجد والتشمير وإلا فقد فاته ربح كثير بما أضاعه من رأس ماله ومنها نقصان رزقه فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه ومنها
ضعف بدنه ومنها زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة فتبدل بها مهانة وحقارة ومنها حصول البغضة والنفرة منه في قلوب الناس ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها وهو الوقت الذي لا عوض منه ولا يعود إليه أبدا ومنها طمع عدوه فيه وظفره به فإنه إذا رآه منقادا مستجيبا لما يأمره اشتد طمعه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه حتى يصير هو وليه دون مولاه الحق ومنها الطبع والرين على قلبه فإن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب منها صقل قلبه وإن أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة أخرى ولا تزال حتى تعلو قلبه فذلك هو الران قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ومنها أنه يحرم حلاوةالطاعة فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان والعقل والرغبة في الآخرة فإن الطاعة تثمر هذه الثمرات ولا بد ومنها أن تمنع قلبه من ترحله من الدنيا ونزوله بساحة القيامة فإن القلب لا يزال مشتتا مضيعا حتى يرحل من الدنيا وينزل في الآخرة فإذا نزل فيها أقبلت إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة واجتمع على جمع أطرافه وقضاء جهازه وتعبئة زاده ليوم معاده وما لم يترحل إلىالآخرة ويحضرها فالتعب والعناء والتشتت والكسل والبطالة لازمة له لا محالة ومنها إعراض الله وملائكته وعباده عنه فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه فأعرضت عنه ملائكته وعباده كما أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه ومنها أن الذنب يستدعي ذنبا آخر ثم يقوى أحدهما بالآخر فيستدعيان ثالثا ثم تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعا وهلم جرا حتى تغمره ذنوبه وتحيط به خطيئته قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه وخير له منها من جنسها وغير
جنسها فإنه لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة كما قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فالمؤمن لا يذهب طيباته في الدنيا بل لا بد أن يترك بعض طيباته للآخرة وأما الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول حظوظه كلها وطيباته في الدنيا ومنها علمه بأن أعماله هي زاده ووسيلته إلى دار إقامته فإن تزود من معصية الله أوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجناة وإن تزود من طاعته وصل إلى دار أهل طاعته وولايته ومنها علمه بأن عمله هو وليه في قبره وأنيسه فيه وشفيعه عند ربه والمخاصم والمحاج عنه فإن شاء جعله له وإن شاء جعله عليه ومنها علمه بأن أعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به وتصعد إلى الله به فبحسب قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودها وأعمال الفجور تهوي به وتجذبه إلى الهاوية وتجره إلى أسفل سافلين بحسب قوة تعلقه بها يكون هبوطه معها ونزوله إلى حيث يستقر به قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنها لم تفتح لأرواحهم عند المفارقة بل أغلقت عنها وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى وصلت إلى الله سبحانه فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه تعالى وقامت بين يديه فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين ومنهاخروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله فيخرج بمعصيته منه إلى حيث يصير نهبا للصوص وقطاع الطريق فما الظن بمن خرج من حصن
حصين لا تدركه فيه آفة إلى خربة موحشة هي مأوى اللصوص وقطاع الطريق فهل يتركون معه شيئا من متاعه ومنها أنه بالمعصية قد تعرض لمحق بركته وبالجملة فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علما وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علما فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصيته وفي بعض الآثار يقول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي ومن ذ الذي عصاني فسعد بمعصيتي
السبب الثامن قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه حريص على الانتقال بخير ما بحضرته فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل
السبب التاسع مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس فإن قوةالداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات فإنها تطلب لها مصرفا فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه فإن النفس لا تقعد فارغة بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد
السبب العاشر وهو الجامع لهذه الأسباب كلها ثبات شجرة الإيمان في القلب فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر فإن من باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم عليه وبغضه له ومقته لفاعله وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار امتنع من أن لا يعمل بموجب هذا العلم ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غلط فإذا قوي
سراج الإيمان في القلب وأضاءت جهاته كلها به وأشرق نوره في أرجائه سرى ذل النور إلى الأعضاء وانبعث إليها فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان وانقادت له طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهة بل تفرح بدعوته حين يدعوها كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل كرامته فهو كل وقت يترقب داعيه ويتأهب لموافاته والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فصل والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة ومن أقوى أسبابها الإيمان والمحبة فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه
وههنا مسألة تكلم فيها الناس وهي أي الصبرين أفضل صبر العبد عن المعصية أم صبره على الطاعة فطائفة رجحت الأول وقالت الصبر عن المعصية من وظائف الصديقين كما قال بعض السلف أعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يقوى على ترك المعاصي إلا صديق قالوا ولأن داعي المعصية أشد من داعي ترك الطاعة فإن داعي المعصية إلى أمر وجودي تشتهيه النفس وتلتذ به والداعي إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة والمهانة ولا ريب أن داعي المعصية أقوى قالوا ولأن العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس والهوى والشيطان وأسباب الدنيا وقرناء الرجل وطلب التشبه والمحاكاة وميل اطلبع وكل واحد من هذه الدواعي يجذب العبد إلى المعصية ويطلب أثره فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت على القلب فأي صبر أقوى من صبر عن إجابتها ولولا أن الله يصبره لما تأتى منه الصبر وهذا القول كما ترى حجته في غاية الظهور ورجحت طائفة الصبر على الطاعة بناء منها على أن فعل المأمور أفضل من ترك المنهيات واحتجت على ذلك بنحو من عشرين حجة ولا ريب أن فعل المأمورات
إنما يتم بالصبر عليها فإذا كان فعلها أفضل كان الصبر عليها أفضل وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية فالصبر على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة وصبر العبد على الجهاد مثلا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على صلاة الصبح وصوم يوم تطوعا ونحوه فهذا فصل النزاع في المسألة والله أعلم فصل والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة
أحدها شهود جزائها وثوابها
الثاني شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها
الثالث شهود القدر السابق الجاري بها وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق فلا بد منها فجزعه لا يزيده إلا بلاء
الرابع شهوده حق الله عليه في تلك البلوى وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين الأمة أو الصبر والرضا على أحد القولين فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه
الخامس شهود ترتبها عليه بذنبه كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة فشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة قال علي بن أبي طالب ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة
السادس أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن العبودية
تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه فإن لم يوف قدر المقبام حقه فهو لضعفه فلينزل إلى مقام الصبر عليها فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدى لحق
السابع أن يعلم أن هذه المصيبة هي داء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا
الثامن أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم مالم تحصل بدونه فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الداء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وفي مثل هذا القائل
لعل عتبك محمود عواقبه ... وربما صحت الأجسام بالعلل
التاسع أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملا بس الفضل وجعل أولياءه وحزبه خدما له وعونا له وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديدة وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة
وتشجيع القلب في تلك الساعة والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذا ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات وعن الآخرة بالحرمان والخذلان لأن ذلك تقدير العزيز العليم وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
العاشر أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء فيستخرج من عبوديته في جميع الأحوال فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الأيمان النافع وقت الحاجة وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه فإما أن يخرج تبرا أحمر وإما أن يخرج زغلا محضا وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبا خالصا فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه اللهم أعني على ذكرك وشكر وحسن عبادتك وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء فإن قويت أثمرت الرضا والشكر فنسأل الله أن يسترنا بعافيته ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه فصل المثال السادس الحزن قال أبو العباس وهو من منازل العوام وهو انخلاع عن السرور وملازمة الكآبة لتأسف عن فائت أو توجع لممتنع وإنما كان من منازل العوام لأن فيه نسيان المنة والبقباء في رق الطبع وهو في مسالك الخواص حجاب لأن معرفة الله جلا نورها كل
ظلمة وكشف سرورها كل غمة فبذلك فليفرحوا وقيل أوحى الله إلى داود يا داود بي فافرح وبذكري فتلذذ وبمعرفتي فافتخر فعما قليل أفرغ الدار من الفاسقين وأنزل نقمتي على الظالمين
اعلم أن الحزن من عوارض الطريق ليس من مقامات الإيمان ولا من منازل السائرين ولهذا لم يأمر الله به في موضع قط ولا أثنى عليه ولا رتب عليه جزاء ولا ثوابا بل نهى عنه في غير موضع كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ولا تحزن عليهم ولاتك في ضيق مما يمكرون وقال تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين وقال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله دفعها وكشفها ولهذا يقول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن فحمدوه على أن أذهب عنهم تلك البلية ونجاهم منها وفي الصحيح عن النبي أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال فاستعاذ من ثمانية أشياء كل شيئين منها قرينان فالهم والحزن قرينان وهما الألم الوارد على القلب فإن كان على ما مضى فهو حزن وإن كان على ما يستقبل فهو الهم فالألم الوارد إن كان مصدره فوت الماضي أثر الحزن وإن كان
مصدره خوف الآتي أثر الهم والعجز والكسل قرينان فإن تخلف مصلحة العبد وبعدها عنه إن كان من عدم القدرة فهو عجز وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل والجبن والبخل قرينان فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إلريه فالجن ترك الإحسان بالبدن والبخل ترك الإحسان بالمال وغلبة الدين وقهر الرجال قرينان فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد إما منه وإما من غيره وإن شئت قلت إما بحق وإما بباطل من غيره والمقبصود أن النبي جعل الحزن مما يستغاذ منه وذلك لأن الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن قال تعالى إنما النجوى من ال شيطان ليحزن الذين ءامنوا فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره والثواب عليه ثواب المصائب التي يبتلى العبد بها بغير اختياره كالمرض والألم ونحوهما وأما أن يكون عبادة مأمورا بتحصيلها وطلبها فلا ففرق بين ما يثاب عليه العبد من المأمورات وما يثاب عليه من البليات ولكن يحمد في الحزن سببه ومصدره ولازمه لا ذاته فإن المؤمن إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره في خدمةربه وعبوديته وإما أن يحزن على تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه وعلى حياته حيث شغل قلبه بمثل هذا الألم فحزن عليه ولو كان قلبه ميتا لم يحس بذلك ولم يحزن ولم يتألم فما لجرح بميت إيلام وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى ولكن الحزن لا يجدي عليه فإنه يضعفه كما تقدم بل الذي ينفعه أن يستقبل السير ويجد ويشمر ويبذل جهده وهذا نظير من انقطاع عن رفقته في السفر فجلس في الطرريق حزينا كئيبا يشهد انقطاعه ويحدث نفسه باللحاق بالقوم فكلما فتر وحزن حدث نفسه باللحاق برفقته ووعدها إن
صبرت أن تلحق بهم ويزول عنها وحشة الانقطاع فهكذا السالك إلى منازل الأبرار وديار المقربين وأخص من هذا الحزن حزنه على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب عن تمام سيره وجده في سلوكه فإن التفرقة من أعظم البلاء على السالك ولا سيما في ابتداء أمره فالأول حزن على التفريط في الأعمال وهذا حزن على نقص حاله مع الله وتفرقة قلبه وكيف صار وقته ظرفا لتفرقة حاله واشتغال قلبه بغير معبوده وأخص من هذا الحزن حزنه على جزء من أجزاء قلبه كيف هو خال من محبة لله وعلى جزء من أجزاء بدنه كيف هو منصرف في غير محاب الله فهذا حزن الخاصة ويدخل في هذا حزنهم على كل معارض يشغلهم عما هم بصدده من خاطر أو إرادة أو شاغل من خارج فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق ولكن الكيس لا يدعها تملكه وتقعده بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به فإن المكروه إذا ورد على النفس فإن كانت صغيرة اشتغلت بفكرها فيه وفي حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها به فأورثها الحزن وإن كانت نفسا كبيرة شريفة لم تفكر فيه بل تصرف فكرها إلى ما ينفعها فإن علمت منه مخرجا فكرت في طريق ذلك المخرج وأسبابه وإن علمت أنه لا مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه وكان ذلك عوضا لها من الحزن فعلى كل حال لا فائدة لها في الحزن أصلا والله أعلم وقال بعض العارفين ليست الخاصة من الحزن في شيء وقوله معرفة الله جلا نورها كل ظلمة وكشف سرورها كل غمة كلام في غاية الحسن فإن من عرف الله أحبه ولا بد ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان وعمر قلبه بالسرور والأفراح وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب فإنه لا حزن مع الله ابدا ولهذا قال حكاية عن نبيه أنه قال لصاحبه أبي بكر لا تحزن إن الله معنا فدل أنه لا حزن مع الله وأن من كان الله معه فما له
والحزن وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن ومن فاته الله فبأي شيء يفرح قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به من حبيب أو حياة أو مال أو نعمة أو ملك يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله ولا ينال القلب حقيقب ةالحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجةفيظهر سرورها في قلبه ونضرتها في وجهه فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نضرة وسرورا فلمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فهذا هو العلم الذي شمر إليه أولوا الهمم والعزائم واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم
تلك المكارم لا قعبان من لبن ... شيبا بماء فعادا بعد أبوالا فصل والمثال السابع الخوف قال أبو العباس هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن والتيقظ لنداء الوعيد والحذر من سطوة العقاب وهو من منازل العوام أيضا وليس في منازل الخواص خوف للأنه لا أمان للغافل إنما يعبد مولاه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره ترى الطالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم وأما الخواص أهل الاختصاص فإنهم جعلوا الوعيد منه وعدا والعذاب فيه عذبا لأنهم شاهدوا المبتلى من البلاء والمعذب في العذاب فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا في ذلك قال قائلهم
سقمي في الحب عافيتي ... ووجودي في الهوى عدمي
وعذاب ترتضون به ... في فمي أحلى من النعم
ومن كان مستغرقا في المشاهدة حل في بساط الأنس فلا يبقى للخوف بساحته ألم لأن المشاهدة توجب الأنس والخوف يوجب القبض ثم ذكر حكاية المضروب الذي ضرب مائة سوط فلم يتألم لأجل نظر محبوبه إليه ثم ضرب سوطا فصاح لما توارى عنه محبوبه قال وقد قيل في قوله تعالى والكافرون لهم عذاب شديد دليل خطابه أن المؤمنين لهم عذاب ولكن ليس بشديد وإنما كان عذاب الكفرين شديدا لأنهم لا يشاهدون المعذب لهم والعذاب على شهود المعذب عذب والثواب على الغفة من المعطي صعب فالخوف إذا من منازل العوام
والكلام على ما ذكره من وجوه
أحدها أن الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها وهي الخوف والرجاء والمحبة وقد ذكره سبحانه في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فجمع بين المقامات الثلاثة فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه ثم يقول ويرجون رحمته ويخافون عذابه فذكر الحب والخوف والرجاء والمعنى إن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه فهم عبيده كما أنكم عبيده فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد له وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فجعل الخوف منه شرطا
في تحقيق الإيمان وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى والخوف شرط في حصوله وتحققه وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه وحصول المسبب شرط في تحقيق السبب كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه وانتفاء الخوف عن انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته فتدبره والمعنى إن كنتم مؤمنين فخافوني والجزاء محذوف مدلول عليه بالأول عند سيبويه وأصحابه أو هو المتقدم نفسه وهو جزاء وإن تقدم كما هو مذهب المكوفيين وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي للخوف وهو الإيمان وكل منهما مستلزم للآخر لكن الاستلزام مختلف وكل منهم منتف عند انتفاء الآخر لكن جهة الانتفاء مختلفة كما تقدم والمقصود أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عنه وقال تعالى فلا تحشوا الناس واخشون وقد أثنى سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف منه فقال عن أنبيائه بعد أن ثنى عليهم ومدحهم إنهم كانوا يسارعون في الخيران ويدعوننا رغبا ورهبا فالرغب الرجاء والرغبة والرهب الخوف والخشية وقال عن ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وفي الصحيح عن النبي أنه قال إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية وفي لفظ آخر إني
أخوفكم لله وأعلمكم بما أتقي وكان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وقد قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف قال ابن مسعود وكفى بخشية الله علما ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به فأعرف الناس أخشاهم لله ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا فالخوف من أجل منازل الطريق وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة وهم إليه أحوج وهم بهم أليق ولهم ألزم فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف وهو ينشأ من ثلاثة أمر أحدها معرفته بالجناية وقبحها والثاني تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها والثالث أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه وإما عدم علمه بسوء عاقبته وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان فإذا علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة بل يمنعها ويحال بينه وبينها اشتد خوفه هذا قبل الذنب فإذا عمله كان خوفه أشد
وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزاؤها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج في قلبه من الخوف مالا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز و جل فإن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه كما ثبت عن النبي وكانت أكثر يمينه لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب وقال بعض السلف القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا وقال بعضهم مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلاة تقلبها الرياح ظهرا لبطن ويكفي في هذا قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فأي قرار لمن هذه حاله ومن احق بالخوف منه بل خوفه لازم له في كل حال وإن توارى عنه بغلبة حالة أخرى عليه فالخوف حشو قلبه لكن توارى عنه بغلبة غيره فوجود الشيء غير العلم به فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله وأنه الفعال لما يريد وأنه المحرك للقلب المصرف له المقلب له كيف يشاء لا إله إلا هو
الوجه الثاني قوله وليس في منازل الخواص خوف قد تبين فساده وأن الخاصة أشد خوفا من العامة
الوجه الثالث قوله العاقل يعبد ربه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره ترى الظالمين مشفقين فهذا إنما هو وحشة
ونفار وهو غير الخوف فإن الوحشة إنما تنشأ من عدم الخوف وأما الخوف فإنه يوجب هروبا إلى الله وجميعة عليه وسكونا إليه فهي مخافة مقرونة بجلاوة وطمأنينة وسكينة ومحبة بخلاف خوف المسيء الهارب من الله فإنه خوف مقرون بوحشة ونفرة فخوف الهارب إليه سبحانه محشو بالحلاوة والسكينة والأنس لا وحشة معه وإنما يجد الوحشة من نفسه فله نظران نظر إلى نفسه وجنايته فيوجب له وحشة ونظر إلى ربه وقدرته عليه وعزه وجلاله فيوجب له خوفا مقرونا بأنس وحلاوة وطمأنينة
الوجه الرابع إن استشهاه بقوله ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم ليس استشهادا صحيحا فإن هذا وصف لحالهم في الآخرة عند معانية العذاب أو عند الموت فهذا الإشفاق مقرون بالاستيحاش لأنه قد علم أنه صائر إليه كمن قدم إلى العقوبة ورأى أسبابها فهو مشفق منها إذا رآها لعلمه بأنه صائر إليها فليست الآية من الخوف المأمور به في شيء
والوجه الخامس أن الخوف يتعلق بالأفعال وأما الحب فإنه يتعلق بالذات والصفات ولهذا يزول الخوف في الجنة وأما الحب فيزداد ولما كان الحب يتعلق بالذات كان من أسمائه سبحانه الودود قال البخاري في صحيحه الحبيب وأما الخوف فإن متعلقه أفعال الرب ولا يخرج عن كون سببه جناية العبد وإن كانت جنايته من قدر الله ولهذا قال علي بن أبي طالب لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه فمتعلق الخوف ذنب العبد وعاقبته وهي مفعولات للرب فليس الخوف عائدا إلى نفس الذات والفرق بينه وبين االحب أن الحب سببه الكمال وذاته تعالى لها الكمال المطلق وهو متعلق الحب التام وأما الخوف فسببه
توقع المكروه وهذا إنما يكون في الأفعال والمفعولات وبهذا يعلم بطلان قول من زعم أنه سبحانه يخاف لا لعلة ولا لسبب بل كما يخاف السيل الذي لا يدري العبد من أين يأتيه وهذا بناء من هؤلاء على نفي محبته سبحانه وحكمته وأنه ليس إلا محض المشيئة والإرادة التي ترجح مثلا على مثل بلا مرجح ولا يراعي فيها حكمة ولا مصلحة وهؤلاء عندهم الخوف يتعلق بنفس الذات من غير نظر إلى فعل العبد وأنه سبب المخافة إذ ليس عندهم سبب ولا حكمة بل إرادة محضة يفعل بها ما يشاء من تنعيم وتعذيب وعند هؤلاء فالخوف لازم للعبد في كل حال أحسن أم أساء وليس لأفعاله تأثير في الخوف وهذا من قلة نصيبهم من المعرفة بالله وكماله وحكمته وأين هذا من قول أمير المؤمنين علي لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه فجعل الرجاء متعلقا بالرب سبحانه وتعالى لأن رحمته من لوازم ذاته وهي سبقت غضبه وأما الخوف فمتعلق بالذنب فهو سبب المخافة حتى لو قدر عدم الذنب بالكلية لم تكن مخافة
فإن قيل فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة وشدة خوف النبي مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه أقرب الخلق إلى الله قيل عن هذا أربعة أجوبه
الجواب الأول أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره ونظير هذا في المشاهد أن الماثل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوفا منه من البعد عنه بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه وأنه يطالب من حقوق الخدمة وأدائها بما لا يطالب به
غيره فهو أحق بالخوف من البعيد ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية وفهم قوله في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث زيد بن ثابت عن النبي أنه قال إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم وليس المراد به لو عذبهم لتصرف في ملكه والمتصرف في ملكه غير ظالم كما يظنه كثير من الناس فإن هذا يتضمن مدحا والحديث إنما سيق للمدح بغير استحقاق فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف ما أتوا ولهذا قال بعده ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم يعني أن رحمته لهم ليست على قدر أعمالهم إذ أعمالهم لا تستقبل باقتضاء الرحمة وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيبا لحقه وهو غير ظالم لهم فيه ولا سيما فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم فإذا عذبهم على ترك شكرهم وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عذبهم ولم يكن ظالما لهم
فإن قيل فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما ينبغي له مقدورا لهم فكيف يحسن العذاب عليه قيل الجواب من وجهين
أحدهما أن المقدور للعبد لا يأتي به كله بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان وأيضا ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرا وباطنا فالتقصير لازم
في حال الترك وفي حال الفعل ولهذا سأل الصديق النبي دعاء يدعو به في صلاته فقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فأخبر عن ظلمه لنفسه مؤكدا له بأن المقتضية ثبوت الخبر وتحققه ثم أكده بالمصدر النافي للتجوز والاستعارة ثم وصفه بالكثرة المقتضية لتعدده وتكثره ثم قال فاغفر لي مغفرة من عندك أي لا ينالها عملي ولا سعيي بل عملي يقصر عنها وإنما هي من فضلك وإحسانك لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي ثم قال وارحمني أي ليس معولي إلا على مجرد رحمتك فإن رحمتني وإلا فالهلاك لازم لي فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية وفي ضمنه أنه لو عذبتني لعدلت في ولم تظلمني وإني لا أنجو إلا برحمتك ومغفرتك ومن هذا قوله لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة فلو لم ينجه الله فلم يكن قد بخسه شيئا من حقه ولا ظلمه فإنه ليس معه ما يقتضي نجاته وعمله ليس وافيا بشكر القليل من نعمه فهل
يكون ظالما لو عذبه وهل تكون رحمته له جزاء لعمله ويكون العمل ثمنا لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه وكمال العبودية من الحياء والمراقبة والمحبة والخشوع وحضور القلب بين يدي الله في العمل له ومن علم هذا علم السر في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار ففي صحيح مسلم عن ثوبان قال كان رسول الله إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر فلما كان السحر جلسوا يستغفرون الله وأمر الله تعالى عباده بالاستغفار عقيب الإفاضة في الحج فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وشرع رسول الله للمتوضىء أن يختم وضوءه بالتوحيد والاستغفار فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذا ونحوه مما يبين حقيقة الأمر وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته وأنه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا
الجواب الثاني أنه لو فرض أن العبد يأتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهرا وباطنا فالذي ينبغي لربه فوق ذلك وأضعاف أضعافه فإذا عجز العبد عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء والذي أتى به لا يقابل أقل النعم فإذا حرم جزاء العمل الذي ينبغي للرب من عبده كان ذلك تعذيبا
له ولم يكن الرب ظالما له في هذا الحرمان ولو كان عاجزا عن أسبابه فإنه لم يمنعه حقا يستحقه عليه فيكون ظالما بمنعه فإذا أعطاه الثواب كان مجرد صدقة منه وفضل تصدق بها عليه لا ينالها عمله بل هي خير من عمله وأفضل وأكثر ليست معوضة عليه والله أعلم
الجواب الثالث عن السؤال الأول أن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب وأنه يحول بين المرءوقلبه وأنه تعالى كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم بنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فلولا خوف الإزاغة لما سألوه أن لا يزيغ قلوبهم وكان من داء النبي اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ومثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وفي الترمذي عنه أنه يدعو أعوذ بعزتك أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت وكان من دعائه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب وبفعل العافية من فعل العقوبة واستعاذ به منه باعتبارين وكأن في استعاذته منه جمعا لما فصله في الجملتين قبله فإن الاستعاذة به منه ترجع إلى معنى الكلام قبلها مع تضمنها فائدة شريفة وهي كمال التوحيد وأن الذي يستعيذ به العائذ ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيئته وقدره فهو وحده المنفرد بالحكم فإذا أراد بعبده سوءا لم يعذه
منه إلا هو فهو الذي يريد به ما يسوؤه وهو الذي يريد دفعه عنه فصار سبحانه مستعاذا به منه باعتبار الإرادتين وإن يمسسك الله بضرفلا كاشف له إلا هو فهو الذي يمس بالضر وهو الذي يكشفه لاإله إلا هو فالمهرب منه إليه والفرار منه إليه واللجأ منه إليه كما أن الاستعاذة منه فإنه لا رب غيره ولا مدبر للعبد سواه فهو الذي يحركه ويقلبه ويصرفه كيف يشاء
الجواب الرابع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق أفعال العبد الظاهرة والباطنة فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب ويجعل التوبة والإنابة والإقبال والمحبة والتفويض وأضدادها والعبد في كل لحظة مفتقر إلى هداية يجعلها الله في قلبه وحركات يحركها بها في طاعته وهذا إلى الله سبحانه وتعالى فهو خلقه وقدره وكان من دعاء النبي اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وعلم حصين بن المنذر أن يقول اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي / ح / وعامة أدعيته متضمنة لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماله في محابه فمن هداه وصلاحه وأسباب نجاته بيد غيره وهو المالك له ولها المتصرف فيه بما يشاء ليس من أمره شيء من أحق بالخوف منه وهب أنه قد خلق له في الحال الهداية فهل هو على يقين وعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلقها له في المستقبل ويلهمه رشده أبدا فعلم أن خوف المقربين عند ربهم أعظم من خوف غيرهم والله المستعان ومن ههنا كان
خوف السابقين من فوات الإيمان كما قال بعض السلف أنتم تخافون الذنب وأنا أخاف الكفر وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة نشدتك الله هل سماني لك رسول الله يعني في المنافقين فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا رواه البخاري يعني لا أفتح علي هذا الباب في سؤال الناس لي وليس مراده أنه لم يخلص من النفاق غيرك
الوجه السادس قوله وأما الخواص فإنهم جعلوا الوعيد منه وعدا والعذاب فيه عذبا لأنهم شاهدوا المبتلى والمعذب فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا إلى آخر كلامه فيقال هذا الكلام ونحوه من رعونات النفس ومن الشطحات التي يجب إنكارها فمن ذا الذي جعل وعيد الله وعدا وعقابه ثوابا وعذابه عذابا وهل هذا إلا إنكار لوعيده وعذابه في الحقيقة وأي عذاب أشد من عذابه نعوذ بالله منه قال تعالى ولكن عذاب الله شديد وقال فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه أحد وهذا أظهر في كل ملة من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه وإنما ينسب هذا المذهب إلى الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود كما قال قائلهم
ولم يبق إلا صادق الوعد ووحده ... فما لوعيد الحق غير تعاين
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم ... على لذة فيها نعيم مباين
يسمى عذابا من عذوبة طعمه ... وذاك له كالقشر والقشر صائن
نعيم جنان الخلد والأمر واحد ... وبينهما عند التجلي تباين
فهذا القائل خط على تلك النقطة التي نقطها أبو العباس ولعل الكلامين من مشكاة واحدة وهذا مباين للمعلوم بالاضطرار من دين الرسل وما أخبرت به عن الله وأخبر به على لسان رسول الله فإن قيل ليس مراده ما ذكرتم وفهمتم من كلامه وإنما مراده أنه سبحانه إذا ابتلى عبده في الدنيا فهو لكمال محبته له يتلذذ بتلك البلوى ويعدها نعمة وليس مراده عذاب الآخرة قيل قوله عن الخواص أنهم جعلوا الوعيد منه وعدا ينفي ما ذكرتم من التأويل فإن ابتلاء الدنيا غير الوعيد وأيضا فإنه في مقام الخوف ونفيه عن الخاصة محتجا عليه بأنهم يرون العذاب عذبا والوعيد وعدا فما لهم وللخوف هذا مقصوده من سياق كلامه واحتجاجه عليه بهذا الهذيان الذي يسخر منه العقلاء بل نحن لا ننكر أن العبد إذا تمكن حب الله في قلبه حتى ملك جميع أجزائه فإنه قد يتلذذ بالبلوى أحيانا وليس ذلك دائما ولا أكثريا ولكنه يعرض عند هيجان الحب وغلبة الشوق فيقهر شهود الألم ثم يراجع طبيعته فيذوق الألم ولكن أين هذا من جعل الوعيد وعدا والعذاب عذبا وإن أحسن الظن بصاحب هذا الكلام ظن به أنه ورد عليه وارد من الحب يخيل في نفسه أن محبوبه إذا توعده كان ذلك منه وعدا وإن عذبه كان عذابه عنده عذبا لموافقته مراد محبوبه وهذا خيال فاسد وتقدير في النفس وإلا فالحقيقة الخارجية تكذب هذا الخيال الباطل بل لو صب عليه أدنى شيء من عذابه لصاح واستغاث وطلب العفو والعافية وحكمة الله تقتضي تعجيز هذه النفوس الجاهلة الرعناء الحمقاء بأدنى شيء يكون من الألم والوجع حتى يتبين لها دعاويها الكاذبةوشطحها الباطل وهذا سيد المحبين وسيد ولد آدم استعاذته بالله من عذابه وبلائه وسؤاله عافيته ومعافاته معلومة في أدعيته وتضرعه إلى ربه وابتهاله
إليه في ذلك وهي أكثر وأشهر من أن تذكر ههنا وإن ما في سيد المحبين أسوة وقدوة ولكن قد ابتلي كثير من أهل الإرادة بالشطح كما ابتلي كثير من أهل الكلام بالشك والمعافى من عافاه الله من هذا وهذا فنسأل الله عافيته ومعافاته
الوجه السابع قوله إن عذاب الكافرين إنما كان شديدا لأنهم لا يشاهدون المعذب لهم والمؤمنون يشاهدونه فلم يكن عذابهم شديدا وليس كذلك فإن عذاب الكافرين شديد في نفسه لغلظ جرمهم وهو الكفر وهو دائم لا انقطاع له وأما المؤمنون الذين يعذبون بذنوبهم فعذابهم أضعف من عذاب الكافرين لأن عذابهم على الذنوب وهي دون الكفر وهو منقطع والأية لم يرد بها إثبات عذاب المؤمنين دون عذاب الكافرين وإنما سيقت لبيان عذاب الكافرين فحسب فمفهومها نفي العذاب عن المؤمنين لا إثبات عذاب غير شديد والله أعلم
الوجه الثاني قوله وللخواص الهيبة وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف والخوف يزول بالأمن وينتهي به خوف الشخص على نفسه من العقاب فإذا أمن العقاب زال الخوف والهيبة لا تزول أبدا لأنها مستحقة للرب بوصف التعظيم والإجلال وذلك الوصف مستحق على الدوام وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة وتصدم المشاهد أحيان المشاهدة وتعصم العائن بصدمة العزة ومنه قال قائلهم
أشتاقه فإذا بدا ... أطرقت من إجلاله
لا خيفة بل هيبة ... وصيانة لجماله
وأصد عنه تجلدا ... وأروم طيف خياله
فيقال من العجائب أن المعنى الذي أمر الله به في كتابه وأثنى به على خاصة عباده وأقربهم إليه وهم أنبياؤه ورسله وملائكته يجعل ناقصا من منازل العوام ويعمد إلى معنى لا يذكره الله ولا رسوله ولا علق به على المدح والثناء في موضع واحد فيجعل هو الكمال وهو للخواص من العباد فأين في القرآن والسنة ذكر الهيبة من لوازم الإيمان وموجباته ولكن المنكر أن يكون الوصف الذي وصف به أنبياءه وملائكته ناقصا والوصف الذي لم يذكره هو الكامل التام وهذا المعنى المعبر عنه بالهيبة حق ولكن لم تجىء العبارة عنه في القرآن والسنة بلفظ الهيبة وإنما جاءت بلفظ الإجلال كقول النبي إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والإمام العادل فالإجلال هو التعظيم وكذلك الهيبة يوضح هذا
الوجه التاسع وهو أن الهيبة والإجلال يجوز تعلقهما بالمخلوق كما قال النبي إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم الحديث وقال ابن عباس عن عمر هيبته وكان مهيبا وأما البخشية والمخافة فلا تصلح إلا لله وحده قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وقال فلا
تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال إنما يعمر مساجد الله من ءامن بالله واليوم الأخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فالخوف عبودية القلب فلا تصلح إلا لله كالذل والمحبة والإنابة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب وكيف يجعل المهابة المشتركة أفضل منه وأعلى وتأمل قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك الفائزون كيف جعل الطاعة لله ولرسوله والخشية والتقوى له وحده وقال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه كيف جعل التوقير والتعزير للرسول وحده والتوقير هو التعظيم الصادر عن الهيبة والإجلال هذه حقيقته فعلم أن الخوف من أجل مقامات الخواص وأنهم إليه أحوج وبه أقوم من غيرهم
الوجه العاشر قوله الخوف يزول بالأمن والهيبة لا تزول أبدا إلخ فيقال هذا حق فإن الخوف إنما يكون قبل دخول الجنة فإذا دخلوها زال عنهم الخوف الذي كان يصحبهم في الدنيا وفي عرصات القيامة وبدلوا به أمنا لأنهم قد أمنوا العبذاب فزايلهم الخوف منه ولكن لا يدل على هذا أنه كان مقاما ناقصا في الدنيا كما أن الجهاد من أشرف المقامات وقد زال عنهم في الآخرة وكذلك الإيمان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق وقد زال في الآخرة وصار الأمر شهادة وكذلك الصلاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النفس لله وهي من أشرف الأعمال وكلها تزول في الجنة وهذا لا يدل على نقصانها فإن الجنة ليست دار سعي وعمل إنما هي دار نعيم وثواب
الوجه الحادي عشر أن الخوف إنما زال في الجنة لأن تعلقه إنما هو بالأفعال لا بالذات كما تقدم وقد أمنهم ما كانوا يخافون منه فقد أمنوا أن لا يفعلوا ما يخافون منه وأن يفعل بهم ربهم ما يخيفهم ولكن كان الخوف في الدنيا أنفع لهم فبه وصلوا إلى الأمن التام فإن الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده مخافتين اثنتين فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة ومن أمنه في الدنيا ولم يخفه أخافه في الآخرة وناهيك شرفا وفضلا بمقام ثمرته الأمن الدائم المطلق
الوجه الثاني عشر أن الإجلال والمهابة والتعظيم إنما لم تزل لأنها متعلقة بنفس الذات وهي موجودة في دار النعيم وأما الخوف فإنه إنما زال لأنه وسيلة إلى توفية العبودية والقيام بالأمر والوسيلة تزول عند حصول الغاية ولكن زوال الوسيلة عند حصول الغاية لا يدل على انها ناقصة وإذا كانت تلك الغاية لا كمال للعبد بدونها فالوسيلة إليها كذلك
الوجه الثالث عشر قوله وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة وتصون المشاهد أحيان المشاهدة وتعصم المعاني بصدمة العزة فيقال لا ريب أن الحب والأنس المجرد عن التعظيم والإجلال يبسط النفس ويحملها على بعض الدعاوي والرعونات والأماني الباطلة وإساءة الأدب والجناية على حق المحبة فإذا قارن المحبة مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه وشهود عز جلاله وعظيم سلطانه انكسرت نفسه له وذلت لعظمته واستكانت لعزته وتصاغرت لجلاله وصفت من رعونات النفس وحماقاتها ودعاويها الباطلة وأمانيها الكاذبة ولهذا في الحديث يقول الله عز و جل أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي فقال أين المتحابون بجلالي فهو حب بجلاله وتعظيمه ومهابته
ليس حبا لمجرد جماله فإنه سبحانه الجليل الجميل والحب الناشىء عن شهود هذين الوصفين هو الحب النافع الموجب لكونهم في ظل عرشه يوم القيامة فشهود الجلال وحده يوجب خوفا وخشية وانكسارا وشهد الجمال وحده يوجب حبا بانبساط وإذلال ورعونة وشهود الوصفين معا يوجب حبا مقرونا بتعظيم وإجلال ومهابة وهذا هو غاية كمال العبد والله أعلم وإنشاده هذه الأبيات الثلاثة في هذا المقام في غاية القبح فإن هذا المحب ينفي خوفه من محبوبه ويعرض عنه إظهارا للتجلد أمام رقيبه وذلك قبيح في حكم المحبة فإن التذلل للمحبوب وتملقه واستعطافه والانكسار له أولى بالمحب من تجلده وتعززه كما قيل
اخضع وذل لمن تحب فليس في ... شرع الهوى أنف يشال ويعقد
ثم أخبر أنه يروم طيف خياله فهو طالب لحظه من محبوبه لا لمراد محبوبه منه فهذا محب لنفسه وقد جعل طيف محبوبه وسيلة إلى حصول مراده فأحبه حب الوسائل بخلاف من قد أحب محبوبه لذات المحبوب ففني عن مراده هو منه بمراد محبوبه فصار مراده مراد محبوبه فحصل الاتحاد في المراد لا في الإرادة ولا في المريد هذا إن كان صبره عنه تجلدا عليه وإن كان تجلدا على الرقيب خوفا منه فهو ضعيف المحبة لأن فيه بقية ليست مع محبوبه بل مع رقيبه فهلا ملأ الحب قلبه فلم يبق فيه بقية يلاحظ بها الرقيب والعاذل كما قيل
لا كان من لسواك فيه بقبية ... يجد السبيل بها إليه العذل
وبالجملة فهذه أبيات ناقصة المعنى لا يصلح الاستشهاد بها والله أعلم فصل والمقصود الكلام على علل المقامات وبيان ما فيها من خطأ وصواب ولما كان أبو العباس بن العريف قد تعرض لذلك في كتابه محاسن المجالس ذكرنا فيه وما له وما عليه ثم ذكر بعد هذا فصلا
في المحبة وفصلا في الشوق فنذكر كلامه في ذلك وما يفتح الله به تتميما لفائدة ورجاء للمنفعة وأن يمن الله العزيز الوهاب بفضله ورحمته ويرقي عبده من العلم إلى الحال ومن الوصف إلى الاتصاف إنه قريب مجيب
قال أبو العباس وأما المحبة فقد أشار أهل التحقيق في العبارة عنها وكل نطق بحسب ذوقه وانفسح بمقدار شوقه قلت الشيء إذا كان في الأمور الوجدانية الذوقية التي إنما تعلم بآثارها وعلاماتها وكان مما يقع في التفاوت بالشدة والضعف وكان له لوازو وآثار وعلامات متعددة اختلفت العبارات عن بحسب اختلاف هذه الأشياء وهذا شأن المحبة فإنها ليست بحقيقة معانيها ترى بالأبصار فيشترك الواصفون لها في الصفة وهي في نفسها متفاوتة أعظم تفاوت كما بين العلاقة التي هي تعلق القلب بالمحبوب والخلة التي هي أعلى مراتب الحب وبينهما درجات متفاوتة تفاوتا لا ينحصر ولها آثار توجبها وعلامات تدل عليها فكل أدرك بعض علاماتها فعبر بحسب ما أدركه وهي وراء ذلك كله ليس اسمها كمسماها ولا لفظها مبين لمعناها وكذلك اسم المصيبة والبلية والشدة والألم إنما تدل أسماؤها عليها نوع دلالة لا تكشف حقيقتها ولا تعلم حقيقتها إلا بذوقها ووجودها وفرق بين الذوق والوجود وبين التصور والعلم فالحدود والرسوم التي قيلت في المحبة صحيحة غير وافية بحقيقتها بل هي إشارات وعلامات وتنبيهات فصل قال وهي على الإجمال قبل أن ننتهي إلى التفصيل وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير محبوبه فيقال هذا التعظيم المانع من الانقياد لغير المحبوب هو أثر من آثار المحبة وموجب من موجباتها لا أنه نفس المحبة فإن المحبة إذا كانت صادقة أوجبت للمحب تعظيما لمحبوبه يمنعه من انقياده إلى غيره وليس مجرد التعظيم هو المانع له من الانقياد إلى غيره بل التعظيم المقارن للحب هو الذي يمنع من
الانقياد إلى غير المحبوب فإن التعظيم إذا كان مجردا عن الحب يمنع انقياد القلب إلى غير المعظم وكذلك إذا كان الحب خاليا من التعظيم لم يمنع المحب أن ينقاد إلى غير محبوبه فإذا اقترن الحب بالتعظيم وامتلأ القلب بهما امتنع انقياده إلى غير المحبوب والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع أحدها محبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء وغير ذلك وهذه تستلزم التعظيم والنوع الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوها وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم والنوع الثالث محبة أنس وإلف وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر بعضهم بعضا وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله سبحانه ولهذا كان رسول الله يحب الحلواء والعسل
وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد
وكان أحب اللحم إليه الذراع
وكان يحب نساءه وكانت عائشة رضي الله عنها أحبهن إليه
وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق وأما المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا وهي التي سوى المشركون بين آلهتهم وبين الله فيها كما قال تعالى ومن الناس من يتحذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين ءامنوا أشد حبا لله وأصح القولين أن المعنى يحبونهم كما يحبون الله وسووا بين الله وبين أندادهم في الحب ثم نفى ذلك عن المؤمنين فقال والذين ءامنوا أشد حبا لله فإن الذين آمنوا وأخلصوا حبهم لله لم يشركوا به معه غيره وأما المشركون فلم يخلصوا لله والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه المحبة وهي أول دعوة الرسل وآخر كلام العبد المؤمن الذ إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه المحبة وإفراد الرب بها فهو أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا إلى الله وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لها وجميع المقامات وسائل إليها وأسباب لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل فهي قطب رحى
السعادة وروح الإيمان وساق شجرة الإسلام ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد فالكتاب هاد إليها ودال عليها ومفصل لها والحديد لمن خرج عنها وأشرك فيها مع الله غيره ولأجلها خلقت الجنة والنار فالجنة د دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده فأخلصهم لها والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره وسوى بينه وبين الله فيها كما أخبر تعالى عن أهلها أنهم يقولون في النار لآلهتهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله سبحانه في أفعاله وصفاته وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها في المحبة والعبودية مع إقرارهم بالفرق بين الله وبينها فتصحيح هذه هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله فحقيق لمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة علما وعملا وحالا وتكون أهم الأشياء عنده وأجل علومه وأعماله فإن الشأن كله فيها والمدار عليها والسؤال يوم القيامة عنها قال تعالى فوربك لنسئلنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال غير واحد من السلف هو عن قول لا إله إلا الله وهذا حق فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها قال أبو العالية كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون ماذا أجبتم المرسلين فالسؤال عماذا كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسها والسؤال عماذا أجابوا المرسلين سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها هل سلكوها وأجابوا لما دعوهم إليها فعاد الأمر كله إليها وأمر هذا شأنه حقيق بأن تنعقد عليه الخناصر ويعض عليه بالنواجذ ويقبض فيه على الجمر ولا يؤخذ بأطراف الأنامل ولا بطلب على فضله بل يجعل هو
المطلب الأعظم وما سواه إنما يطلب على الفضلة والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه فصل قال وقيل المحبة إيثار المحبوب على غيره وهذا الحد أيضا من جنس ما قبله فإن إيثار المحبوب على غيره موجب المحبة ومقتضاها فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحبة إيثار محبوبه على غيره وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها فإذا آثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا له وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه فإذا رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه فهذا موضع يغلط فيه الناس كثيرا إذ أكثرهم إنما هو يحب لحظه ومراده فإذا علم أنه عند غيره أحب ذلك الغير حب الوسائل لا حبا له لذاته ويظهر هذا عند حالتين إحداهما أنه يرى حظا له آخر عند غيره فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه الثانية أنه إذا نال ذلك الحظ من محبوبه فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه كما قيل من ودك لأمر ولى عند انقضائه فهذه محبة مشوبة بالعلل بل المحبة الخالصة أن يحب المحبوب لكماله وأنه أهل أن يحب لذاته وصفاته وأن الذي يوجب هذه المحبة فناء العبد عن إرادته لمراد محبوبه فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه فهذه هي المحبة الخالصة من درن العلل وشوائب النفس وهي التي تتزايد وفي مثل هذا قيل
تعصي الإله وأن تزعم حبه ... هذا لعمرك في القياس شنيع
لو كان حبك صادقا لأطعته ... إن المحب لمن يحب مطيع
وههنا دقيقة ينبغي التفطن لها وهي أن إيثار المحبوب نوعان إيثار معاوضة ومتاجرة وإيثار حب وإرادة فالأول يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه فهو يبذل ما يؤثره ليعاوضه بخير منه والثاني يؤثره إجابة لداعي
محبته فإن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار محبوبه فإيثاره هو أجل حظوظه فحظه في نفس الإيثار لا في العوض المطلوب بالإيثار وهذا لا تفهمه إلا النفس اللطيفةالورعة المشرقة وأما النفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذا وما هو بعشها فلتدرج
والدين كله والمعاملة في الإيثار فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك حتى إن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثر إذ لو لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما وهذا إنما يصح في إيثار المخلوق والله سبحانه يؤثر عبده على غيره من غير احتياج منه سبحانه فإنه الغني الحميد وفي الدعاء المرفوع اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر لينا وأرضنا وارض عنا وقيل من آثر الله على غيره آثره الله على غيره والفرق بين الإيثار والأثرة أن الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك والأثرة اختصاصك به على الغير وفي الحديث بايعنا رسول الله على لاسمع والطاعة في عسرنا ويسرنا وننشطنا ومكرهنا وأثرة علينا
فإذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق وإما أن يتعلق بيالخالق وإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يمنع لك واردا فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفلسك عليهم أولى فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان وهذا في غاية الصعوبة على السالك والأول أسهل منه فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عيانا مفلسا فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله ومما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها وهذا ضد الإيثار بها قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض تعالى وقال فاستبقوا الخيرات وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال النبي لو يعلم الناس ما
في النداء والصف الأول لكانت قرعة والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا للإيثار بل محلا للتنافس والمسابقة ولهذا قال الفقهاء لا يستحب الإيثيار بالقربات والسر فيه والله أعلم أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه فلا يسع المؤثر والمؤثر بل لا يسع إلا أحدهما وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها فلو اشتركت الألوف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ووسعتهم كلهم وإن قدر التزاحم ي عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع بحيث إذا فعله واحد فات على غيره فإن في العزو والنية الجازة على فعله من الثواب ما لفاعله كما ثبت عن النبي في غير حديث فإذا قدر فوت
مباشرته له فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله وأيضا فإنه إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض منه إما مساو له وإما أزيد وإما دونه فمتى أتى بالعوض وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقة إرادته لذلك العمل الفائت أعطاه الله ثوابه وثواب ما تعوض به عنه فجمع له الأمرين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأيضا فإن المقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه والمنافسة في محابه والإيثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنه وتركه له وعدم المنافسة فيه وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من طعامه وشرابه ولباسه إذا كان أخوه محتاجا إليه فإذا اختص به أحدهما فات الآخر فندب الله عبده إذا وجد من نفسه قوة وصبرا على الإيثار به ما لم يخرم عليه دينا أو يجلب له مفسدة أو يقطع عليه طريقا عزم على سلوكه إلى ربه أو شوش عليه قلبه بحيث يجعله متعلقا بالخلق فمفسدة إيثار هذا أرجح من مصلحته فإذا ترجحت مصلحة الإيثار بحيث تتضمم إنقاذ نفسه من هلكة أو عطب أو شدة ضرورة وليس للمؤثر نظيرها تعين عليه الإيثار فإن كان به نظيرها لم يتعين عليه الإيثار ولكن لو فعله لكان غاية الكرم والسخاء والإحسان فإنه من آثر حياة غيره على حياته وضرورة على ضرورته فقد استولى على أمد الكرم والسخاء وجاوز أقصاه وضرب فيه بأوفر الحظ وفي هذا الموضع مسائل فقهية ليس هذا موضع ذكرها فإن قيل فما الذي يسهل على النفس هذا الإيثار فإن النفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار قيل يسهله أمور
أحدها رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه ومحبته كما جبلها على بغض المستأثر ومقته لا تبديل لخلق الله والأخلاق ثلاثة خلق الإيثار وهو خلق الفضل وخلق القسمة والتسوية وهو خلق العدل وخلق الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظلم فصاحب
الإيثار محبوب مطاع مهيب وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذاه والتسلط عليه ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها وصاحب الاستئثار النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل في حدوره وهل أزال المملك وقلعهاإلا الاستئثار فإن النفوس لا صبر لها عليه ولهذا أمر رسول الله أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم لما في طاعة المستأثر من المشقة أو لكره الاستئثار
الثاني النفرة من أخلاق اللئام ومقت الشح وكراهته له
الثالث تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض فهو يرعاها حق رعايتها ويخاف من تضييعها ويعلم أنه إن لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حده فإن ذلك عسر جدا بل لا بد من مجاوزته إلى الفضل أو التقصير عنه إلى الظلم فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه ولا يضره ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة مع ما يجلبه له الإيثار من البركة وفيضان الخير عليه فيعود عيه من إيثاره أفضل مما بذله ومن جرب هذا عرفه ومن لم يجربه فليستقر أحوال العالم والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى فصل والإيثار المتعلق بالخالق أجل من هذا وأفضل وهو إيثار رضاه على رضى غيره وإيثار حبه على حب غيره وإيثار خوفه ورجائه على خوف غيره ورجائه وإيثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره وكذلك إيثار الطلب من هوالسؤال وإنزال الفاقات به على تعلق ذلك بغيره فالأول آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له وهذا آثر الله على غيره ونفسه من أعظم الأغيار فآثر الله عليها فترك
محبوبها لمحبوب الله وعلامة هذا الإيثار شيئان أحدهما فعل ما يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه الثاني ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحبه وتهواه فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار ومؤنة هذا الإيثار شديدة لغلبة الأغيار وقوة داعي العادة والطبع فالمحنة فيه عظيمة والمؤنة فيه شديدة والنفس عنه ضعيفة ولا يتم فلاح العبد وسعادته إلا به وإنه ليسير على من يسره الله عليه فحقيق بالعبد أن يسمو إليه وإن صعب المرتقى وأن يشمر إليه وإن عظمت فيه المحنة ويحمل فيه خطرا يسير لملك عظيم وفوز كبير فإن ثمرة هذا في العاجل والآجل ليست تشبه ثمرة شيء من الأعمال ويسير منه يرقي العبد ويسيره ما لا يرقى غيره إليه في المدد المتطاولة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا تتحقق المحبة إلا بهذا الإيثار والذي يسهله على العبد أمور أحدها أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسة ليست بجافية ولا قاسية بل تنقاد معه بسهولة الثاني أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته الثالث قوة صبره وثباته فبهذه الأمور الثلاثة ينهض إلى هذا المقام ويسهل عليه دركه والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من أمرين أن تكون جامدة غير سريعة الإدراك بل بطيئة ولا تكاد ترى حقيقة الشيء إلا بعد عسر وإن رأتها اقترنت به الأوهام والشكوك والشبهات والاحتمالات فلا يتخلص له رؤيتها وعيانها الثاني أن تكون القريحة وقادة دراكة لكن النفس ضعيفة مهينة إذا أبصرت الحق والرشد ضعفت عن إيثاره فصاحبها يسوقها سوق العليل المريض كلما ساقه خطوة وقف خطوة أو كسوق الطفل الصغير الذي تعلقت نفسه بشهواته ومألوفاته فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفت إلى لهوه ولعبه لا ينساق معه إلا كرها فإذا رزق العبد قريحة وقادة وطبيعة منقادة إذا زجرها انزجرت وإذا قادها انقادت بسهولة وسرعة ولين وارتدى مع ذلك بعلم نافع وإيمان راسخ أقبلت إليه وفود السعادة من كل جانب
ولما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة رضي الله عنهم
وكملها الله لهم بنور الإسلام وقوة اليقين ومباشرة الإيمان لقلوبهم كانوا أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين وكان من بعدهم لو أنفق مثل جب أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ومن تصور هذا الموضع حق تصوره علم من أين يلزمه النقص والتأخر ومن أين يتقدم ويرقى في درجات السعادة وبالله التوفيق والله أعلم
فصل قال وقيل المحبة موافقة المحبوب فيما ساء وسر ونفع وضر كما قيل
وأهنتني فأهنت نفسي صاغرا ... ما من يهون عليك ممن أكرم
فيقال وهذا الحد أيضا جنس ما قبله فإن موافقة المحبوب من موجبات المحبة وثمراتها وليست نفس المحبة بل المحبة تستدعي الموافقة وكلما كانت المحبة أقوى كانت الموافقة أتم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الحسن قال قوم على عهد النبي إنا نحب ربنا فأنزل الله تعالى هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الحسن قال قوم على عهد النبي انا نحب ربنا فأنزل الله تعالى هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الجنيد ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني
أن متابعة الرسول هي موافقة حبيبكم فإنه المبلغ عنه ما يحبه وما يكرهه وقال مالك في هذه الآية من أحب طاعة الله أحبه الله وحببه إلى خلقه وإنما كانت موافقة المحبوب دليلا على محبته لأن من أحب حبيبا فلا بد أن يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه وإلا لم يكن محبا له محبة صادقة بل إن تخلف ذلك عنه لم يكن له محبا له بل يكون محبا لمراده منه أحبه محبوبه أم كرهه ومحبوبه عنده وسيلة إلى ذلك المراد فلو حصل له حظه من غيره ترحل عوضه فهذه المحبة المدخولة الفاسدة وإذا كانت المحبة الصحيحة تستدعي حب ما يحبه المحبوب وبغض ما يبغضه فلا بد أن يوافقه فيه
ولكن ههنا مسألة يغلط فيها كثير من المدعين للمحبة وهي أن موافقة المحبوب في مراده ليس المعنى بها مراده الخلقي الكني فإن كل الكون مراده وكل ما يفعله الخلائق فهو موجب مشيئته وإرادته الكونية فلو كانت موافقته في هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو أصلا وكانت الشياطين والكفار والمشركون عباد الأوثان والشمس والقمر أولياءه وأحبابه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما يظن ذلك من يظنه من أعدائه الجاحدين لمحبته ودينه والذين يسوون بين أوليائه وأعدائه قال الله تعالى أم نجعل الذين ءامنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال الله تعالى أم حسبت الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين ءامنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون وبين المطيعين والمفسين مع أن الكل تحت المراد
الكوني والمشيئة العامة وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قال لي بعض شيوخ هؤلاء المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب والكون كله مراده فأي شيء أبغض منه قال فقلت له فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض ما في الكون فأبغض قوما ومقتهم ولعنهم وعاداهم فأحببتهم أنت وواليتهم تكون مواليا للمحبوب موافقا له أو مخالفا له معاديا له قال فكأنما ألقم حجرا ويبلغ الجهل والكفر ببعض هؤلاء إلى حد بحيث إذا فعل محظورا يزعم أنه مطيع لله سبحانه وتعالى ويقول أنا مطيع لإرادته وينشد في ذلك
أصبحت منفعلا لما يختاره ... مني ففعلي كله طاعات
ويقول أحدهم إبليس وإن عصى الأمر لكنه أطاع الإرادة يعني أن فعله طاعة لله من حيث موافقة إرادته وهذا انسلاخ من ربقة العقل والدين وخروج عن الشرائع كلها فإن الطاعة إنما هي موافقة الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه وأما دخوله تحت القدر الكوني الذي يبغضه ويسخطه ويكفر فاعله ويعاقبه فهي المعصية والكفر ومعاداته ومعاداة دينه ولا ريب أن المسرفين على أنفسهم المنهمكين في الذنوب والمعاصي المعترفين بأنهم عصاة مذنبون أقرب إلى الله من هؤلاء العارفين المنسلخين عن دين الأنبياء كلهم الذين لا عقل لهم ولا دين فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه
أما البيت الذي استشهد به فهو من أبيات لأبي الشيص من قصيدة يقول فيها
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي ... متأخر عنه ولا متقدم
وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ... ما من يهون عليك ممن يكرم
أشبهت أعدائي فصرت أحبهم ... إذ كان حظي منك حظي منهم
أجد الملامة في هواك لذيذة ... حبا لذكرك فليلمني اللوم
وقد ناقض فيها في دعواه مناقضة بينة فإنه أخبر أن هواه قد صار
وقفا عليها لا يزول عنها ولا يتحول بتقدم ولا تأخر ثم أخبر أنه قد بلغ به حبها وهواها إلى أن صار مرادها من نفسه غير مراده هو فلما أرادت إهانته بالصد والهجران والبعد سعى هو في إهانة نفسه بجهده موافقة لها في إرادتها فصارت إهانته لنفسه مرادة محبوبه له من حيث هي مرادة محبوبة لها وزعم أنه لو أكرم نفسه لكان مخالفا لمحبوبته مكرما لمن أهانته ثم نقض هذا الغرض من حيث شبهها بأعدائه الذين هم أبغض شيء إليه ووجه هذا التشبيه أنه لم يحصل منها من حظه ومراده على شيء بل الذي يحصل له منها مثل ما يحصل له من أعدائه من إهانتهم له وأذاه فصار حظه منها ومن أعدائه واحدا فصارت شبيهة لهم فأين هذا من الموافقة التامة لها في مرادها بحيث يهين نفسه لمحبتها في إهانته ثم أخبر أن له منها حظا مرادا وأن ذلك الحظ الذي يريده لم يحصل له وإنما حصل له منه نظير ما يحصل له من أعدائه وهذه شكاية في الحقيقة وإخبار عن محبه ببخله بالحظ وشكاية للحبيب بتفويته عليه ثم إنه أخبر عن جناية أخرى وهي أنه شرك بينهما وبين أعدائه في حبه لها فصار حبه منقسما بعضه له وبعضه لأعدائه لشبههم إياها ثم إن في الشعر جناية أخرى عليها وهو أنه شبهها بمن جبلت القلوب على بغضه وهو العدو واللائق تشبيه الحبيب بما هو أحب الأشياء إلى النفس كالسمع والبصر والحياة والروح والعافية كما هو عادة الشعراء والناس في نظمهم ونثرهم كما هو معروف بينهم وهو جادة كلامهم ثم أخبر بمحبته لأعدائه لشبههم بها فتضمن كلامه معاداة من يحبه ومحبة من يعاديه فإنها إذا أشبهت أعداءه لزم أن يحصل لها نصيب من معاداته وإذا أشبهها أعداؤه لزم أن يحصل لهم نصيب من محبته كما صرح به في جانبهم وترك التصريح في جانبها وهو مفهوم من كلامه ثم أخبر أنه يلتذ بملامة اللوام في هواها لما يتضمن من ذكراها وهذا يدل على قوة محبتها وسماع ذكرها وهذا غرض صحيح مع أنه مدخول أيضا فإن محبوبته قد تكره
ذلك لما يتضمن من فضيحتها به وجعلها مضغة للماضغين فيكون محبا لنفس ما تكرهه وهذه محبة فاسدة معلولة ناقضة لدعواه موافقتها في محابها
فصل قال وقيل المحبة القيام بين يديه وأنت قاعد ومفارقة المضجع وأنت راقد والسكون وأنت ناطق ومفارقة المألوف والوطن وأنت مستوطن فيقال وهذا أيضا أثر من آثار المحبة وموجب من موجباتها وحكم من أحكامها وهو صحيح فإن المحبة توجب سفر القلب نحو المحبوب دائما والمحبة وطنه وتوجب مثوله وقيامه بين يدي محبوبه وهو قاعد وتجافيه عن مضجعه ومفارقته إياه وهو فيه راقد وفراغه لمحبوبه كله وهو مشغول في الظاهر بغيره كما قال بعضهم
وأديم نحو محدثي ليرى ... أن قد عقلت وعندكم عقلي
وقال بعض المريدين لشيخه أيسجد القلب بين يدي الله فقال نعم سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة فهذه سجدة متصلة بقيامه وقعوده وذهابه ومجيئه وحركته وسكونه وكذلك يكون جسده في مضجعه وقلبه قد قطع المراحل مسافرا إلى حبيبه فإذا أخذ مضجعه اجتمع عليه حبه وشوقه فيهزه المضجع إلى مسكنه كما قال الله تعالى في حق المحبين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فلما تجافت جنوبهم عن المضاجع جافت الجنوب عنها واستخدمتها وأمرتها فأطاعتها وقال القائل
نهاري نهار الناس حتى إذا بدا ... لي الليل هزتني إليك المضاجع
ويحكى أن بعض الصالحين اجتاز بمجسد فرأى الشيطان واقفا ببابه لا يستطيع دخوله فنظر فإذا فيه رجل نائم وآخر قائم يصلي فقال له أيمنعك هذا المصلي من دخوله فقال كلا إنما يمنعني ذلك الأسد
الرابض ولولا مكانه لدخلت وبالجملة فقلب المحب دائما في سفر لا ينقضي نحو محبوبه كلما قطع مرحلة له ومنزلة تبدت له أخرى كما قيل إذا قطعت علما بدا علم فهو مسافر بين أهله وظاعن وهو في داره وغريب وهو بين إخوانه وعشيرته ويرى كل أحد عنده ولا يرى نفسه عند أحد فقوة تعلق المحب بمحبوبه توجب له أن لا يستقر قلبه دون الوصول إليه وكلما هدأت حركاته وقلت شواغله اجتمعت عليه شؤون قلبه بله قوى سيره إلى محبوبه
ومحك هذا الحال يظهر في مواطن أربعة
أحدها عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل واجتماع قلبه على ما يحبه فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به
الموطن الثاني عند انتباهه من النوم فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه فإنه إذا استيقظ وردت إليه روحه رد معها إليه ذكر محبوبه الذي كان قد غاب عنه في النوم ولكن كان قد خالط روحه وقلبه فلما ردت إليه الروح أسرع من الطرف رد إليه ذكر محبوبه متصلا بها مصاحبا لها فورد عليه قبل كل وارد وهجم عليه قبل كل طارق فإذا وردت عليه الشواغل والقواطع وردت على محل ممتلىء بمحبة ما يحبه فوردت على ساحته من ظاهرها فإذا قضى وطره منها قضاه بمصاحبته لما في قلبه من الحب فإنه قد لزمه ملازمة الغريم لغريمه ولذلك يسمى غراما وهو الحب اللازم الذي لا يفارق فسمع بمحبوبه وأبصر به وبطش به ومشى به فصار محل سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها هذا مثل محبوبه في وجوده وهو غير متحد به بل هو قائم بذاته مباين له وهذا المعنى مفهوم بين الناس لا ينكره منهم إلا غليظ الحجاب أو قليل العلم ضعيف العقل يجد محبوبه قد استولى على قلبه وذكره فيظن أنه هو نفس ذاته الخارجة قد اتحدت به أو حلت
فيه فينشأ من قسوة الأول وكثافته غلظ حجاب ومن قلة علم الثاني ومعرفته وضعف تمييزه ضلال الحلول والاتحاد وضلال الإنكار والتعطيل والحرمان ويخرج للبصير من بين فرث هذا ودم هذا لبن الفطرة الأولى خالصا سائغا للشاربين
الموطن الثالث عند دخوله في الصلاة فإنها محك الأحوال وميزان الإيمان بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه فإنها محل المناجاة والقربة ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربه فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه منها إذا كان محبا فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له ومثوله بين يديه وقد أقبل محبوبه عليه وكان قبل ذلك معذبا بمقاساة الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهم فإذا قام إلى الصلاة هرب من سوى الله إليه وآوى عنده واطمأن بذكره وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته فلا شيء أهم إليه من الصلاة كأنه في سجن وضيق وغم حتى تحضر الصلاة فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح كما قال النبي لبلال يا بلال أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا منها كما يقول المبطلون الغافلون وقال بعض السلف ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه أو كما قال فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة فلهم فيها شأن وللنقارين شأن يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا ائتموا بهم كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامه فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم بالجملة فمن كان قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده منها ويود
أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرها وإنما يسلي نفسه إذا فارقها بأنه سيعود إليها عن قرب فهو دائما يثوب إليها ولا يقضي منها وطرا فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة فإنها الميزان العادل الذي وزنه غير عائل
الموطن الرابع عند الشدائد والأهوال فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب واللقاء وهو كثير في أشعارهم كما قال
ذكرتك والخطي يخطر بيننا ... وقد نهلت مني المثقفة السمر
وقال غيره
ولقد ذكرتك والرماح كأنها ... أشطان بئر في لبان الأدهم
وقد جاء في بعض الآثار يقول تبارك وتعالى إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه والسر في هذا والله أعلم أن عند مصائب الشدائد والأهوال يشتد خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه وهي حياته التي لم يكن يؤثرها إلا لقربه من محبوبه فهو إنما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه فإذا خاف فوتها بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته ولهذا والله أعلم كثيرا ما يعرض للعبد عند موته لهجه بما يحبه وكثرة ذكره له وربما خرجت روحه وهو يلهج به وذكر ابن أبي
الدنيا في كتاب المحتضرين عن زفر أنه جعل يقول عند موته لها ثلاثة أخماس الصداق لها ربع الصداق لها كذا ومات لامتلاء قلبه من محبة الفقه والعلم وأيضا فإنه عند الموت تنقطع شواغله وتبطل حواسه فيظهر ما في القلب ويقوى سلطانه فيبدو ما فيه من غير حاجب ولا مدافع وكثيرا ما سمع من بعض المحتضرين عند الموت شاه مات وسمع من آخر بيت شعر لم يزل يغني به حتى مات وكان مغنيا وأخبرني رجل عن قرابة له أنه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش قال فجعل يقول هذه قطعة جيدة هذه على قدرك هذه مشتراها رخيص يساوي كذا وكذا حتى مات والحكاية في هذا كثيرة جدا فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته
فصل وقد قيل في المحبة حدود كثيرة غير ما ذكره أبو العباس فقيل المحبة ميل القلب إلى محبوبه وهذا الحد لا يعطي تصور حقيقة المحبة فإن المحبة أعرف عند القلب من الميل وأيضا فإن الميل لا يدل على حقيقة المحبة فإنها أخص من مجرد ميل القلب إذ قد يميل قلب العبد إلى الشيء ولا يكون محبا له لمعرفته بمضرته له فإن سمي هذا الميل محبة فهو اختلاف عبارة وقيل المحبة علم المحب بجمال المحبوب ومحاسنه وهذا حد قاصر فإن العلم بجماله ومحاسنه هو السبب الداعي إلى محبته فعبر عن المحبة بسببها وقيل المحبة تعلق القلب بالمحبوب وقيل انصباب القلب إلى المحبوب وقيل سكون القلب إليه وقيل اشتغال القلب بالمحبوب بحيث لا يتفرغ قلبه لغيره وقيل
المحبة بذل المجهود في معرفة محبوبك وبذل المجهود في مرضاته وقيل هيجان القلب عند ذكر المحبوب وقيل شجرة تنبت في القلب تسقى بماء المراقبة وإيثار رضى المحبوب وقيل المحبة حفظ الحدود فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده وقيل المحبة إرادة لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر وقيل المحبة هي السخاء بالنفس للمحبوب وقيل المحبة أن لا يزال عليك رقيب من المحبوب لا يمكنك من الانصراف عنه أبدا وأنشد في ذلك
أبت غلبات الشوق إلا تقربا ... إليك ويأبى العذل إلا تجنبا
وما كان صدي عنك صد ملامة ... ولا ذلك الإعراض إلا تقربا
وما كان ذاك العذل إلا نصيحة ... ولا ذلك الإغضاء إلا تهيبا
علي رقيب منك حل بمهجتي ... إذا رمت تسهيلا علي تصعبا
وقيل المحبة سقوط كل محبة من القلب سوى محبة حبيبك وقيل المحبة صدق المجاهدة في أوامر الله وتجريد المتابعة لسنة رسول الله وقيل المحبة أن لا يفتر من ذكره ولا يأنس بغيره وقال أبو يزيد المحبة استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك وقيل المحبة أن يميتك حبيبك وتحيا به وقال أبو عبدالله القرشي المحبة أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء وقيل أن تمحو من قلبك ما سوى المحبوب وقيل المحبة نسيان حظك من محبوبك وفقرك بكلك إليه وقال النصر أباذي المحبة مجانبة السلو على كل حال وقال الحارث بن أسد المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا وجهرا ثم علمك بتقصيرك في حبه وقيل المحبة سكر لا يصحو إلا بمشاهدة المحبوب وقيل المحبة إقامتك بالباب على الدوام وقيل المحبة حرفان حاء وباء فالحاء الخروج عن الروح وبذلها للمحبوب والباء الخروج عن البدن وصرفه في طاعة المحبوب وقال أبو عمر الزجاجي سألت الجنيد عن المحبة فقال تريد
الإشارة قلت لا قال تريد الدعوى قلت لا قال فأيش تريد قلت عين المحبة فقال أن تحب ما يحب الله في عباده وتكره ما يكره الله في عباده وقيل المحبة معية القلب والروح مع المحبوب معية لا تفارقه فإن المرء مع من أحب وقد قيل في المحبة حدود أكثر من هذا وكل هذا تعن ولا توصف المحبة ولا تحد بحد أوضح من المحبة ولا أقرب إلى الفهم من لفظها وأما ذكر الحدود والتعريفات فإنما يكون عند حصول الإشكال والاستعجام على الفهم فإذا زال الإشكال وعدم الاستعجام فلا حاجة إلى ذكر الحدود والتعريفات كما قال بعض العارفين إن كل لفظ يعبر به عن الشيء فلا بد أن يكون ألطف وأرق منه والمحبة ألطف وأرق من كل ما يعبر به عنها
فصل قال أبو العباس وقال قوم ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها فإن الغيرة من أوصاف المحبة والغيرة تأبى إلا التستر والاختفاء وكل من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها فليس له منها ذوق وإنما حركة وجدان الرائحة ولو ذاق منها شيئا لغاب عن الشرح والوصف فإن المحبة لا تظهر على المحب بلفظه وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب لموضع اقتداح الأسرار من القلوب كما قيل
تشير فأدري ما تقول بطرفها ... وأطرق طرفي عند ذاك فتعلم
تكلم منا في الوجوه عيوننا ... فنحن سكوت والهوى يتكلم
قلت كل معنى فله صيغة تعبر به عنه ولا سيما إذا كانت من المعاني المعروفة للخاص والعام ولكن العبارة قد تكون كاشفة للمعنى مطابقة له كلفظ الدراهم والخبز والماء واللبن ونحوها وهي أكبر الألفاظ وقد يكون المعنى فوق ما يشير إليه اللفظ ويعبر عنه وهو أجل من أن يدل لفظه على كمال ماهيته وهذا كأسماء الرب سبحانه وأسماء كتابه وكذلك
اسم الحب فإنه لا يكشف اسمه مسماه بل مسماه فوق لفظه وكذلك اسم الشوق والعشق والموت والبلاء ونحوها وقد يكون المعنى دون اللفظ بكثير واللفظ أجل منه وأعظم وهذا كلفظ الجوهر الفرد الذي هو عبارة عن أقل شيء وأصغره وأقه وأحقره فليس معناه على قدر لفظه وإذا عرف هذا فقولهم ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها المراد به أن لفظها لا يفهم حقيقة معناها ومعناها فوق ما يفهم من لفظها وقوله الغيرة من أوصاف المحبة وهي تأبى إلا التستر والاختفاء هذا كلام في حكم المحبة ومقتضاها لا في حقيقتها ومعناها والمحبون متباينون في هذا الحكم فمنهم من يجعل الغيرة من لوازم المحبة وعلامة ثبوتها وتمكنها ويجعل نداء المرء عليها وبسط لسانه بالإخبار بها دليلا على أنه دعي فيها وأن ما معه منها رائحتها لا حقيقتها وحقيقتها تأبى إلا التستر والكتمان وهذه طريقة الملامين كما قيل
لا تنكري جحدي هواك فإنما ... ذاك الجحود عليه ستر مسبل
ولهذا قيل المحبة كتمان الإرادة وإظهاره الموافقة وهذه الطائفة رأت أن كمال المحبة بكتمانها لأسباب عديدة
أحدها أن الحب كلما كان مكتوما كان أشد وأعظم سريانا وسكونا في أجزاء القلب كلها كما قيل الحب أقتله أكتمه فإذا أفشاه المحب وأظهره وباح به ونادى عليه ضعف أثره وصار عرضة للزوال
الثاني أن الحب كنز من الكنوز بل هو أعظم الكنوز المودعة في سر العبد وقلبه فلا طريق للصوص إليه فإذا باح به ونادى عليه فقد دل قطاع الطريق واللصوص على موضع كنزه وعرضه لسلبه منه فإن النفوس غيارة مغيرة تغار على المحبوب أن يشاركها في حبه فانتزعته منه وهذه الآفة قد ابتلي بها كثير من السالكين الذين هم في الحقيقة قطاع الطريق على السالكين إلى الله وسولت لهم أنفسهم أن هذه غيرة منهم على
محبوبهم أن يحب مثل هذه النفوس المتلوثة بالدنيا وغرتهم أنفسهم ومنتهم أنهم يغارون على الله ويحولون بين تلك النفوس وبين المحبة فغاروا وأغاروا ونهبوا واستلبوا وهذه الطريقة عند المحبين المخلصين أولياء الله الداعين إلى الله عداوة لله في الحقيقة ومعاونة للشيطان وقعود على طريق الله المستقيم الذي خلق عباده لأجله وأمرهم به فالحذر من هؤلاء القطاع اللصوص حمل أهل المحبةعلى المبالغة في كتمانها وإظهار التخلي منها بأسباب يلامون عليها ظاهرا وقلوبهم مغمورة بالمحبة مأهولة بها وهذا الذي ظنوه غيرة هو من تلبيس الشيطان وخدعه لهم ومكره بهم وإنما غيرة المحبين لله أن يغار أحدهم لمحارم الله إذا انتهكت فيغار لله على الله كما قال النبي إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه فغيرة المحب هي الموافقة لغيرة محبوبه وهي أن يغار مما يغار منه المحبوب وإذا كان المحبوب ممن يحبه وهذا يغار ممن يحبه الله فهو في الحقيقة ساع في خلاف مراد محبوبه وفي إعدام ما يحبه محبوبه فأن هذا من الغيرة المحبوبة لله وإنما هذه غيرة من أخيه المسلم كيف خصه الله بعطائه وألبسه ثوب نعمائه فهي غيرة منه لا غيرة على الله فإن الله لا يغار عليه بل يغار له وسنفرد إن شاء الله للغيرة فصلا نذكر فيه أقسامها وحقيقتها
الثالث أن المحبة التامة تستدعي شغل القلب بالمحبوب وعدم تفرغه للشرح والوصف فلو صدقت محبته لاستغرق فيها عن شرح حاله ووصفه فهذه طريقة هؤلاء ومنهم من يجعل تهتكه وبوحه بها وإعلامه لها من تمامها وقوتها ومن علامات قهرها له وأنها غلبت على سره حتى لم يطق صبره كتمانها كما قال النوري المحبة هتك الأستار وكشف الأسرار فهذا حال النوري وأضرابه وعند هؤلاء التكتم ضعف في المحبة وجور
فيها وحقيقتها أن تخليها ومقتضاها من ظهور آثارها على الجوارح والبدن فإن أثرت حركة لم يسكنها وإن أثرت دمعة لم يمسكها وإن أثرت تنفسا لم يكظمه وإن أثرت بذلا وإيثارا لم يمسكه وكمال المحبة عندهم أن تنادي عليه أعضاؤه وألفاظه وألحاظه وحركاته وسكناته بالحب نداء لا يملك إنكاره وقال علي بن عبيد وكتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته فكتب إليه أبو يزيد غيرك شرب بحور السموات والأرض ما روي بعد ولسانه خارج وهو يقول هل من مزيد فلم ير هذان العارفان التكتم بها وإخفاءها وجحدها وهما هما وكان الأستاذ أبو علي الدقاق ينشد كثيرا
لي سكرتان وللندمان واحدة ... شيء خصصت به من بينهم وحدي
وجاء رجل إلى عبدالله بن المنازل فقال رأيت في المنام كأنك تموت إلى سنة فقال عبدالله لقد أجلتني إلى أجل بعيد أعيش إلى سنة لقد كان لي أنس ببيت سمعته من أبي علي الثقفي
يا من شكى شوقه من طول فرقته ... اصبر لعلك تلقى من تحب غدا
وقال الشبلي المحب إذا سكت هلك والعارف إن لم يسكت هلك والتحقيق أن هذا هو حال المتمكن في حبه الذي تزول الجبال الراسيات وقلبه على الود لا يلوي ولا يتغير والأول حال المريد المبتدىء الذي قد علقت نار المحبة في قلبه ولم يتمكن اشتعالها فهو يخاف عليها عواصف الرياح أن تطفئها فهو يخبئها ويكتمها ويسترها من الرياح جهده فإذا اشتعلت وتمكن وقودها في القلب لم تزدها كثرة الرياح إلا وقودا واشتعالا فهذا يختلف باختلاف الناس وتفاوتهم في قوة المحبة وضعفها والمقصود أن من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها وأحكامها أن يؤمن أن يكون من أهل العلم بالمحبة لا من المتصفين بها حالا فكم بين العلم بالشيء والاتصاف به ذوقا وحالا فعلم المحبة شيء ووجودها في القلب شيء وكثير من المحبين الذين امتلأت قلوبهم محبة لو سئل عن
حدها وأحكامها وحقيقتها لم يطق أن يعبر عنها ولا يتهيأ له أن يصفها ويصف أحكامها وأكثر المتكلمين فيها إنما تكلموا فيها بلسان العلم لا بلسان الحال وهذا والله أعلم هو معنى قول بعض المشايخ أعظم الناس حجابا عن الله أكثرهم إليه إشارة فإنه إنما حظه من الإشارة إليه لا علوق القلب عليه كالفقير الذي دأبه وصف الأغنياء وأموالهم ووصف الدنيا وممالكها وهو خلو من ذلك ولا ريب أن وجود الحب في القلب وترك الكلام علما خير من كثرة الكلام في هذه المسألة وخلو القلب منها وخير من الرجلين من امتلأ قلبه منها حالا وذوقا وفاضت على لسانه إرشادا وتعليما ونصيحة للأمة فهذا حال الكملة من الناس والله المسؤول من فضله وكرمه
قوله المحبة لا تظهر على المحب بلفظه وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله هذا حق فإن دلالة الحال على المحبة أعظم من دلالة القال عليها بل الدلالة عليها في الحقيقة هو شاهد الحال لا صريح المقال ففرق بين من يقول لك بلسانه إني أحبك ولا شاهد عليه من حاله وبين من هو ساكت لا يتكلم وأنت ترى شواهد أحواله كلها ناطقة بحبه لك قال جعفر قال الجنيد دفع السري إلي رقعة وقال هذه خير لي من سبعمائة قصة وكذا فإذا فيها
ولما ادعيت الحب قالت كذبتني ... فما لي أرى الأعضاء منك كواسيا
فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا ... وتذبل حتى لا تجيب المناديا
وتبخل حتى ليس يبقي لك الهوى ... سوى مقلة تبكي بها وتناجيا
وبالجملة فشاهد الحب الذي لا يكذب هو شاهد الحال وأما شاهد المقال فصادق وكاذب
قوله ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب لموضع اقتداح الأسرار من القلوب يعني أن حقيقة المحبة وسرها لا يفهمه من المحب إلا
محبوبه وذلك لشدة الاتصال الذي بينه وبين محبوبه في الباطن فروحه أقرب شيء إليه والغير وإن علم أنه محب بظهور أثر المحبةعليه وقيام شاهدها لكن لا يدرك تلك اللطيفة والحقيقة التي يدركها المحبوب من محبه لموضع اتصال سره وقرب ما بين الروحين ولا سيما إذا كانت المحبة من الطرفين فهناك العجب والمناجاة والملاطفة والإشارة والعتاب والشكوى وهما ساكنان لا يدري جليسهما بشأنهما
فصل في محبة العوام
قال وأما محبة العوام فهي محبة تنبت من مطالعة المنة وتثبت باتباع السنة وتنمو على الإجابة للغاية وهي محبة تقطع الوسواس وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب وهي طريق العوام عمدة الإيمان فيقال لا ريب أن المحبة درجات متفاوتة بعضها أكمل من بعض وكل درجة خاصة بالنسبة إلى ما تحتها عامة بالنسبة إلى ما فوقها فليس انقسامها إلى خاص وعام انقساما حقيقيا متميزا بالنسبة بفصل يميز أحد النوعين عن الآخر وإنما تنقسم باعتبار الباعث عليها وسببها وتنقسم بذلك إلى قسمين أحدهما محبة تنشأمن الإحسان ومطالعة الآلاء والنعم فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها ولا أحد أعظم إحسانا من الله سبحانه فإن إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلا عن أنواعه أو عن أفراده ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال العبد وله عليه في كل يوم وليلة فيه أربعة وعشرون ألف نعمة فإنه يتنفس في اليوم والليلة أربعة وعشرين ألف نفس وكل نفس نعمة منه سبحانه فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم أربعة وعشرين ألف نعمة فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده ولعلها توازن النعم في الكثرة والعبد لا شعور له بأكثرها أصلا والله سبحانه يكلؤه منها بالليل والنهار كما قال تعالى قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن وسواء كان المعنى من يكلؤكم ويحفظكم منه إذا أراد بكم سوء ويكون يكلؤكم مضمنا معنى يجيركم وينجيكم من بأسه أو كانت من البدلية أي من يكلؤكم بدل الرحمن أي هو الذي يكلؤكم وحده لا كالىء لكم غيره ونظير من هذه قوله ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون على أحد القولين أي عوضكم وبدلكم واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر
جارية لم تأكل المرققا ... ولم تذق من البقول الفستقا
أي لم تأكل الفستق بدل البقول وعلى كلا القولين فهو سبحانه منعم عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده لا حافظ لهم غيره هذا مع غناه التام عنهم وفقرهم التام إليه من كل وجه وفي بعض الآثار يقول تعالى أنا الجواد ومن أعظم مني جودا وكرما أبيت أكلأ عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالعظائم وفي الترمذي أن النبي لما رأى السحاب قال هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يذكرونه ولا يعبدونه وفي الصحيحين عنه أنه قال لا أحد أصبر على اذى سمعه من الله إنهم ليجعلون له الولد وهو يرزقهم
ويعافيهم وفي بعض الآثار يقول الله ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه خلق لهم ما في السموات والأرض وما في الدنيا والآخرة ثم أهلهم وكرمهم وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه وأذن لهم في مناجاته كل وقت أرادوا وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وكتب لهم بالسيئة واحدة فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره غفر له ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب فوفقهم لفعلها ثم قبلها منهم وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله فوفقهم لفعله وكفر عنهم سيئاتهم به وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات وهو الذي أمرهم بها وخلقها لهم وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءها فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء أولا وآخرا وهم محل إحسانه كله منه أولا وآخرا أعطى عبده المال وقال تقرب بهذا إلي أقبله منك فالعبد له والمال له والثواب منه فهو المعطي أولا وخرا فكيف لا يحب من هذا شأنه وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله ويكفر عنه ذنوبه ويوجب له محبته بالتوبة وهو الذي ألهمه إياها ووفقه لها وأعانه عليها وملأ سبحانه وتعالى سماواته من ملائكته واستعملهم في الاستغفار لأهل
الأرض واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم عذاب الجحيم والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته فانظر إلى هذه العناية وهذا الإحسان وهذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد واللطف التام بهم ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل عنهم ويستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم إلى سؤاله فيدعو مسيئهم إلى التوبة ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه وفقيرهم إلى أن يسأله غناه وذا حاجتهم يسأله قضاءها كل ليلة ويدعوهم إلى التوبة وقد حاربوه وعذبوا أولياءه وأحرقوهم بالنار قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وقال بعض السلف انظروا إلى كرمه كيف عذبوا أولياءه وحرقوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة فهذا الباب يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه وتعالى فإن نعمته على عباده مشهودة لهم يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات وقد روي في بعض الأحاديث مرفوعا أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن ورؤية النعم والآلاء وكلما سافر القلب فيها ازدادت محبته وتأكدت ولا نهاية لها
فيقف سفر القلب عندها بل كلما ازداد فيها نظرا ازداد فيها اعتبارا وعجزا عن ضبط القليل منها فيستدل بما عرفه على مالم يعرفه والله سبحانه وتعالى دعا عباده إليه من هذا الباب حتى إذا دخلوا منه دعوا من الباب الآخر وهو باب الأسماء والصفات الذي إنما يدخل منه إليه خواص عباده وأوليائه وهو باب المحبين حقا الذي لا يدخل منه غيرهم ولا يشبع من معرفته أحد منهم بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقا ومحبة وظمأ فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها وأشدها نقصا وأبعدها من كل خير فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه سبحانه وتعالى ولا شيء أكمل منه ولا أجمل فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه سبحانه وتعالى وهو الذي لا يحد كماله ولا يوصف جلاله وجماله ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله بل هو كما أثنى على نفسه وإذا كان الكمال محبوبا لذاته ونفسه وجب أن يكون الله هو المحبوب لذاته وصفاته إذ لا شيء أكمل منه وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته وأفعاله دالة عليها فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل ما أمر إذ ليس في أفعاله عبث ولا في أوامره سفه بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة عليه وكلامه كله صدق وعدل وجزاؤه كله فضل وعدل فإنه إن أعطى فبفضله ورحمته ونعمته وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته
ما للعباد عليه حق واجب ... كلا ولا سعي لديه ضائع
إن عذبوا فبعدله أو نعموا ... فبفضله وهو الكريم الواسع
فصل ولا يتصور نشر هذا المقام حق تصوره فضلا عن أن يوفاه حقه فأعرف خلقه به وأحبهم له يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولو شهد بقلبه صفة واحدة من أوصاف كماله لاستدعت منه المحبة التامة عليها وهل مع امحبين محبة إلا من آثار صفات كماله فإنهم لم يروه في هذه الدار وإنما وصل إليهم العلم بآثار صفاته وآثار صنعه فاستدلوا بما علموه على ما غاب فلو شاهدوه ورأوا جلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى لكان لهم في حبه شأن آخر وإنما تفاوتت منازلهم ومراتبهم في محبته على حسب تفاوت مراتبهم في معرفته والعلم به فأعرفهم بالله أشدهم حبا له ولهذا كانت رسله أعظم الناس حبا له والخليلان من بينهم أعظمهم حبا وأعرف الأمة أشدهم له حبا ولهذا كان المنكرون لحبه من أجهل الخلق به فإنهم منكرون لحقيقة إلهيته ولخلة الخليلين ولفطرة الله التي فطر الله عباده عليها ولو رجعوا إلى قلوبهم لوجدوا حبه فيها ووجدوا معتقدهم نفي محبتهم يكذب فطرهم وإنما بعثت الرسل بتكميل هذه الفطرة وإعادة ما فسد منها إلى الحالة الأولى التي فطرت عليها وإنما دعوا إلى القيام بحقوقها ومراعاتها لئلا تفسد وتنتقل عما خلقت له وهل الأوامر والنواهي إلا خدم ووابع ومكملات ومصلحات لهذه الفطرة وهل خلق الله سبحانه وتعالى خلقه إلا لعبادته التي هي غاية محبته والذل له وهل هيىء الإنسان إلا لها كما قيل
قد هيئوك لأمر لو فطنت له ... فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل
وهل في الوجود محبة حق غير باطلة إلا محبته سبحانه فإن كل محبة متعلقة بغيره فباطلة زائلة ببطلان متعلقها وأما محبته سبحانه فهو الحق الذي لا يزول ولا يبطل كما لا يزول متعلقها ولا يفنى وكل ما
سوى الله باطل ومحبة الباطل باطل فسبحان الله كيف ينكر المحبة الحق التي لا محبة أحق منها ويعترف بوجود المحبة الباطلة المتلاشية وهل تعلقت المحبة بوجود محدث إلا الكمال في وجوده بالنسبة إلى غيره وهل ذلك الكمال إلا من آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء وهل الكمال كله إلا له فكل من أحب شيئا لكمال ما يدعوه إلى محبته فهو دليل وعبرة على محبة الله وأنه أولى بكمال الحب من كل شيء ولكن إذا كانت النفوس صغارا كانت محبوباتها على قدرها وأما النفوس الكبار الشريفة فإنها تبذل حبها لأجل الأشياء وأشرفها والمقصود أن العبد إذا اعتبر كل كمال في الووجود وجده من آثار كماله سبحانه فهو دال على كمال مبدعه كما ان كل علم في الوجود فمن آثار علمه وكل قدرة فمن آثار قدرته ونسبة الكمالات الموجودة في العالم العلوي والسفلي إلى كماله كنسبة علوم الخلق وقدرهم وقواهم وحياتهم إلى عمله سبحانه وقدرته وقوته وحياته فإذا لا نسبة أصلا بين كمالات العالم وكمال الله سبحانه فيجب أن لا يكون بين محبته ومحبه غيره من الموجودات له بل يكون حب العبد لكه أعظم من حبه لكل شيء بما لا نسبة بينهما ولهذا قال تعالى والذين ءامنوا أشد حبا لله فالمؤمنون أشد حبا لربهم ومعبودهم من كل محب لك محبوب هذا مقتضى عقد الأيمان الذي لا يتم إلا به وليست هذه المسألة من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منها بد كدقائق العلم والمسائل التي يختص بها بعض الناس دون بعض بل هذه مسألة تفرض على العبد وهي أصل عقد الإيمان الذي لا يدخل فيه الداخل إلا بها ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بها فليشتغل بها العبد أو ليعرض عنها ومن لم يتحقق بها علما وحالا وعملا لم يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله فإنها سرها وحقيقتها ومعناها وإن أبى ذلك الجاحدون وقصر عن
علمه الجاهلون فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه وليس ذلك إلا الله وحده ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام وكان أهلها أهل الله وحزبه والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته فهذه المسألة قطب رحى الدين الذي عليه مداره وإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله وأحواله وأقواله ولا حول ولا قوة إلا بالله
فلنرجع إلى شرح كلامه فقوله وأما محبة العوام فهي محبة تنبت من مطالعة المنة يعني أن لهذه المحبة منشأ وثبوتا ونموا فمنشؤها الإحسان ورؤية فضل الله ومنته على عبده وثبوتها باتباع أوامره التي شرعها على لسان رسول الله ونموها وزيادتها يكون بإجابة العبد لدواعي فقره وفاقته إلى ربه فكلما دعاه قره وفاقته إلى ربه أجاب هذا الداعي وهو فقير بالذات فلا يزال فقره يدعوه إليه فإذا دامت استجابته له بدوام الداعي لم تزل المحبة تنمو وتتزايد فكلما أخطر الرب في قلبه خواطر الفقر والفاقة بادر قلبه بالإجابة والانكسار بين يديه ذلا وفاقة وحبا وخضوعا وإنما كانت هذه محبة العوام عنده لأن منشأها من الأفعال لا من الصفات والجمال ولو قطع الإحسان عن هذه القلوب لتغيرت وذهبت محبتها أو ضعفت فإن باعثها إنما هو الإحسان ومن ودك لأمر ولى عند انقضائه فهو برؤية الإحسان مشغول وبتوالي النعم عليه محمول
قوله وهي محبة تقطع الوساوس وتلذذ الخدمة وتسلي على المصائب وهي في طريق العوام عمدة للإيمان إنما كانت هذه المحبة قاطعة للوسواس لإحضار المحب قلبه بين يدي محبوبه والوسواس إنما ينشأ من الغيبة والبعد وأما الحاضر المشاهد فما له وللوسواس فالموسوس
يجاهد نفسه وقبه ليحضر بين يدي معبوده والمحب لم يغب قلبه عن محبوبه فيجاهده على إحضاره فالوسواس والمحب ةمتنافيان ومن وجه آخر أن المحب قد انتقطعت عن قلبه وساوس الأطماع لامتلاء قلبه من محبة حبيبه فلا تتوارد على قلبه جواذب الأطماع والأماني لاشتغاله بما هو فيه وأيضا فإن الوسواس والأماني إنما تنشأ من حاجته وفاقته إلى ما تعلق طمعه به وهذا عبد قد جنى من الإحسان وأعطي من النعم ما سد حاجته وأغنى قافته فلم يبق له طمع ولا وسواس بل بقي حبه للمنعم عليه وشكره له وذكره إياه في محل وساوسه وخواطره لمطالعة نعم الله عليه وشهوده منها ما لم يشهد غيره وقوله وتلذذ الخدمة هو صحيح فإن المحب يتلذذ بخدمة محبوبه وتصرفه في طاعته وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذه الطاعة والخدمة أكمل فليزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان ولينظر هل هو ملتذ بخدمة محبوبه أو متكره لها يأتي بها على السآمة والملل والكراهة فهذا محك إيمان العبد ومحبته لله قال بعض السلف إني أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها ويضيق صدري إذا فرغت أني خارج منها ولهذا قال النبي جعلت قرة عيني في الصلاة ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه فإن قرة عين العبد نعيمه وطيب حياته به وقال بعض السلف إني لأفرح بالليل حين يقبل لما يلتذ به عيشي وتقر به عيني من مناجاة من أحب وخلوتي بخدمته والتذلل بين يديه وأغتم للفجر إذا طلع لما أشتغل به بالنهار عن ذلك فلا شيء ألذ للمحب من خدمة محبوبه وطاعته وقال بعضهم تعذبت بالصلاة عشرين سنة ثم تنعمت بها عشرين سنة وهذه اللذة والتنعم بالخدمة إنما تحصل بالمصابرة والتعب أولا فإذا صبر عليه وصدق في صبره أفضى به الى هذه اللذة قال أبو زيد سقت نفسي إلى الله وهي تبكي فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك
ولا يزال السالك عرضة للآفات والفتور والانتكاس حتى يصل إلى هذه الحالة فحينئذ يصير نعيمه في سيره ولذته في اجتهاده وعذابه في فتوره ووقوفه فترى أشد الأشياء عليه ضياع شيء من وقته ووقوفه عن سيره ولا سبيل إلى هذا إلا بالحب المزعج
وقوله وسلا عن المصائب صحيح فإن المحب يتسلى بمحبوبه عن كل مصيبة يصاب بها دونه فإذا سلم له محبوبه لم يبال بما فاته فلا يجزع على ما ناله فإنه يرى في محبوبه عوضا عن كل شيء ولا يرى في شيء غيره عوضا منه أصلا فكل مصيبة عنده هينة إذا أبقت عليه محبوبه ولهذا لما خرجت تلك المرأة الأنصارية يوم أحد تنظر ما فعل برسول الله مرت بأبيها وأخيها مقتولين فلم تقف عندهما وجاوزتهما تقول ما فعل رسول الله فقيل لها ها هو ذا حي فلما نظرت إليه قالت ما أبالي إذا سلمت هلك من هلك ولو لم يكن في المحبة من الفوائد إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها شرفا فإن المصائب لازمة للعبد لا محيد له عنها ولا يمكن دفعها بمثل المحبة وهكذا مصائب الموت وما بعدها إنما تسهل وتهون بالمحبة وكذلك مصائب القيامة وأعظم المصائب مصيبة النار ولا يدفعها إلا محبة الله وحده ومتابعة رسوله
فالمحبة أصل كل خير في الدنيا والآخرة كما قال سمنون ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة فإن النبي قال المرء مع من أحب فهم مع الله
وقوله وهي في طريق العوام عمدة الإيمان كلام قاصر فإنها عمود الإيمان وعمدته وساقه الذي لا يقوم إلا عليه فلا إيمان بدونها البتة وإنما مراده هذه المحبة الخاصة التي تنشأ من رؤية النعم هي عمدة إيمان العوام وأما الخواص فعمدة إيمانهم محبة تنشأ من معرفة الكمال ومطالعة الأسماء والصفات والله أعلم
قال أبو العباس وأما محبة الخواص فهي محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت ولا تعرف إلا بالحيرة والسكوت وقال بعضهم
يقول وقد ألبست وجدا وحيرة ... وقد ضمنا بعد التفرق محضر
ألست الذي كنا نحدث أنه ... ولوع بذكراها فأين التذكر
فرد عليه الوجد أفنيت ذكره ... فلم يبق إلا زفرة وتحسر
فيقال ههنا مرتبتان من المحبة مختلف في أيتهما أكمل من الأخرى إحداهما هذه المرتبة التي أشار إليها المصنف وهي الدرجة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام في منازله فقال والدرجة الثالثة محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت وهذه المحبة قطب هذا الشأن وما دونها مجال تنادي عليها الألسن وادعتها الخليقة وأوجبتها القول والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل ومن تبعه دون هذه المرتبة وهي المحبة التي تنشأ من مطالعة الصفات فقال في منازله والدرجة الثانية محبة تبعث على إيثار الحق على غيره ويلهج اللسان بذكره ويعلق القلب بشهوده وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر في الآيات والارتياض بالمقامات وإنما جعل هؤلاء هذه المحبة أنقص من المحبة الثالثة بناء على أصولهم فإن الفناء هو غاية السالك التي لا غاية له وراءها فهذه المحبة لما أفنت المحب واستغرقت روحه بحيث غيبته عن شهوده وفني فيها المحب وانمحت رسومه بالكلية ولم يبق هناك إلا محبوبه وحده فكأنه هو المحب لنفسه بنفسه إذ فني من لم يكن وبقي من لم يزل ولما ضاق نطاق النطق بهم عن التعبير عنها عدلوا إلى التعبير عنها بكونها قاطعة للعبارة مدققة للإشارة يعني تدق عنها الإشارة ولأن الإشارة تتناول محبا ومحبوبا وفي هذه المحبة قد فني المحب فانقطع تعلق الإشارة به إذ الإشارة لا تتعلق بمعدوم وسر هذا المقام عندهم هو الفناء في الحب بحيث لا يشاهد له رسما ولا محبة ولا سببا ولهذا كانت الدرجتان اللتان قبله عنه معلولتين لأنهما مصحوبتان بالبقاء وشهود الأسباب بخلاف الثالثة ولهذا قال ولا تنتهي بالنعوت يعني أن النعت لا يصل إليها ولا يدركها وهذا بناء على قاعدته في كل باب من أبواب كتابه يجعل الدرجة العالية التي تتضمن الفناء أكمل مما قبلها والصواب أن الدرجة الثانية أكمل من هذه وأتم وهي درجة الكملة من المحبين ولهذا كان إمامهم وسيدهم وأعظمهم حبا في الذروة العليا من المحبة وهو
مراع لجريان الأمور ولجريان الأمة مثل سماعه بكاء الصبي في الصلاة فيخففها لأجله
ومثل التفاته في صلاته إلى الشعب الذي بعث منه العين يتعرف له أمر العدو وهذا هو في أعلى درجة المحبة ولهذا رأى ما رأى في ليلة الإسراء وهو ثابت الجأش حاضر القلب لم يفن عن تلقي خطاب ربه وأوامره ومراجعته في أمر الصلاة مرارا
ولا ريب أن هذا الحال أكمل من حال موسى الكليم فإن موسى خر صعقا وهو في مقامه في الأرض لما تجلى ربه للجبل والنبي قطع تلك المسافات وخرق تلك الحجب وأى ما رأى وما زاغ بصره وما طغى ولا اضطراب فؤاده ولا صعق ولا ريب أن الوراثة المحمدية أكمل من الوراثة الموسوية وتأمل شأن النسوة اللاتي رأين يوسف كيف أدهشهن حسنه وتعلقت قلبوهن به وأفناهن عن أنفسهن حتى قطعن أيديهن وامرأة العزيز
أكمل حبا منهن له وأشد ولم يعرض لها ذلك مع أن حبها أقوى وأتم لأن حبها كان مع البقاء وحبهن كان مع الفناء فالنسوة غيبهن حسنه وحبه عن أنفسهن فبلغن من تقطيع أيديهن ما بلغن وامرأة العزيز لم يغبها حبه لها عن نفسها بل كانت حاضرة القلب متمكنة في حبها فحالها حال الأقوياء من المحبين وحال النسوة حال أصحاب الفناء ومما يدل على أن حال البقاء في الحب أكمل من حال الفناء أن الفناء إنما يعرض لضعف النفس عن وارد المحبة فتمتلىء به وتضعف عن حمله فيفنيها ويغيبها عن تمييزها وشهودها فيورثها الحيرة والسكوت وأما حال البقاء فيدل على ثبابت النفس وتمكنها وأنها حملت من الحب مالم يطق حمله صاحب الفناء فتصرفت في حبها ولم يتصرف فيها والكمال من إذا ورد عليه الحال تصرف هو فيه ولا يدع حاله يتصرف فيه وأيضا فإن البقاء متضمن لشهود كمال المحبوب ولشهود ذل عبوديته ومحبته ولشهود مراضيه وأوامره والتمييز بين ما يحبه ويكرهه والتمييز بين المحبوب إليه والأحب والعزم على إيثار الأحب إليه فكيف يكون الفاني عن شهود هذا التغييب الحب له أكمل وأقوى وأي عبودية للمحبوب في فناء المحب في محبته وهل العبودية كل العبودية إلا في البقاء والصحو وكمال التمييز وشهود عزة محبوبه وذله وهو في حبه واستكانته فيه اجتماع أرادته كلها في تنفيذ مراد محبوبه فهذا وأمثاله مما يدل على أن الدرجة الثانية التي أشار إليها أكمل من الثالثة وأتم هكذا في جميع أبواب الكتاب والله أعلم
وكأني بك تقول لا يقبل في هذا إلا كلام من قطع هذه المفاوز حالا وذوقا وأما الكلام فيها بلسان العمل المجرد فغير مقبول والمحبون أن أصحاب الحال والذوق في المحبة لهم شأن وراء الأدلة والحجج فاعلم أولا أن كل حال وذوق ووجد وشهود لا يشرق عليه نور العلم المؤيد بالدليل فهو من عبث النفس وحظوظها فلو قدر أن المتكلم إنما تكلم بلسان العلم المجرد فلا ريب أن ما كشفه العلم الصحيح المؤيد بالحجة
أنفع من حال يخالف العلم والعلم يخالفه وليس من الإنصاف رد العلم الصحيح بمجرد الذوق والحال وهذا أصل الضلالة ومنه دخل الداخل على كثير من السالكين في تحكيم أذواقهم ومواجيدهم على العلم فكانت فتنة في الأرض وفساد كبير وكم قد ضل وأضل محكم الحال على العلم بل الواجب تحكيم العلم على الحال ورد الحال إليه فما زكاه شاهد العلم فهو المقبول وما جرحه شاهد العلم فهو المردود وهذه وصية أرباب الاستقامة من مشايخ الطريق يوصون بذلك ويخبرون أن كل ذوق ووجد لا يقوم عليه شاهدان اثنان من العلم فهو باطل ويقال ثانيا ليس من شرط قبول العلم بالشيء من العالم به أن يكون ذائقا له أفتراك لا تقبل معرفة الآلام والأوجاع وأدويتها إلا ممن قد مرض بها وتداوى بها أفيقول هذا عاقل ويقال ثالثا أتريد بالذوق أن يكون القائل قد بلغ الغاية القصوى في هذه المرتبة فلا يقبل إلا ممن هذا شأنه أو تريد أنه لا بد أن يكون له أذواق أهله من حيث يحمله فإن أردت الأول لزمك ن لا يقبل أحد من أحد إذ ما من ذوق إلا وفوقه أكمل منه وإن أردت الثاني فمن أين لك نفيه عن صاحب العلم ولكن لإعراضك عن العلم وأهله صرت تظن أن أهل العلم لهم العلم والكلام والوصف وللمعرضين عنه الذوق والحال والاتصاف والظن يخطىء تارة ويصب والله أعلم
فصل قال أبو العباس فعند القوم كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته وإنما عين الحقيقة عندهم أن يكون قائما بإقاماته له محبا بمحبته له ناظرا بنظره لا من غير أن يبقىمعه بقية تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بنظر أو تنعت بنعت أو توصف بوصف أو تنسب إلى وقت صم بكم عمي لدينا محضرون فيقال هذا هو مقام الفناء الذي يشير إليه كثير من المتأخرين ويجعلونه غاية الغايات ونهاية النهايات
وكل ما دونه فمرقاة إليه وعيلة عليه ولهذا كانت المحبة عندهم آخر منازل الطريق وأول أودية الفناء والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحو وهي آخر منزل يلقى فيه مقدمة العامة ساقة الخاصة وما دونها أعراض الإعراض فجعلوا المحبة منزلا من المنازل ليست غاية وجعلوها أول الأدوية التي سلك فيها أصحاب الفناء فهي أول أوديتهم والعقبة التي ينحدرون منها إلى منازل الفناء والمحو فليست هي الغاية عندهم وأصحابها عندهم مقدمة العامة وساقة أصحاب الفناء عندهم مقدمون عليهم سابقون لهم فإنهم ساقة الخاصة وهؤلاء مقدمة العامة فهذا كله بناء على أن الفناء هو الغاية التي لا غاية للعبد وراءها ولا كمال له يطلبه فوقها وقد تبين ما في ذلك وما هو الصواب بحمد الله كمال له يطلبه فوقها وقد تبين ما في ذلك وما هو الصواب بحمد الله فقوله كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته يقال له إذا كان إنما منته العبودية التي يحبها الله كسبا ومباشرة فهو قائم بها شاهد لمقيمه فيها مطالع لمنته وفضله فأي علة هنا سوى وقوفه مع شهودها منه وغيبته عن شهود إقامة الله وتحريكه إياه وتوفيقه له فالعلة هي بهذا الشهود وهذه الغيبة المنافية لكمال الافتقار والفاقة إلى الله وأما شهود فقره وفاقته ومجموع حالاته وحركاته وسكناته إلى وليه وباريه مستعينا به أن يقيمه في عبودية خالصة له فلا علة هناك قوله وإنما عين الحقيقة أن يكون قائما بإقامته له إلى آخر كلامه يقال إن أردت أنه يشهد إقامة الله له حتى قام ومحبته له حتىلا أحبه ونظره إلى عبده حتى أقبل عبده عليه ناظرا إليه بقلبه فهذا حق فإن ما من الله سبق ما من العبد فهو الذي أحب عبده أولا فأحبه العبد وأقام العبد في طاعته فقام بإقاماته ونظر إليه فأقبل العبد عليه تاب عليه أولا فتاب إليه العبد وإن أردت أنه لا يشهد فعله البتة بل يفنى عنه جملة ويشهد أن الله وحده هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه المحب لنفسه وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدما في شهوده وإن لم تفن
وتعدم في الخارج وهذا هو مراد القوم فدعوى أن هذا هو الكمال الذي لا كمال فوقه ولا غاية وراءه دعوى مجردة لا يستدل عليها مدعيها بأكثر من الذوق والوجد وقد تقدم أن هذا ليس بغاية وإنما غايته أن يكون من عوارض الطريق وأن شهود الأشياء في مراتبها ومنازلها التي أنزلها سبحانه إياها أكمل وأتم ويكفي في بعض هذا الاحتجاج عليه بصفات الكفار فإن الله ذمهم بأنهم صم بكم عمي فهذه صفات نقص وذم لا صفات كمال ومدحة وهل الكمال إلا في حضو السمع والبصر والعقل وكمال التمييز وتنزيل الخلق والأمر منازلهما والتفريق بين ما فرق الله بينه فالأمر كله فرقان وتمييز وتبيين فكلما كان تمييز العبد وفرقانه أتم كان حاله أكمل وسيره أصح وطريقه أقوم وأقرب والحمد لله رب العالمين
فصل قال أبو العباس وأما الشوق فهو هبوب القلب إلى غائب وإعواز الصبر عن فقده وارتياح السر إلى طلبه وهو من مقامات العوام وأما الخواص فهو عندهم مخلة عظيمة لأن الشوق إنما يكون إلى غائب ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة والطريق عندهم أن يكون العبد غائبا والحق ظاهرا ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب ولا سنة صحيحة إلا أن الشوق مخبر عن بعد ومشير إلى غائب وهو يطلع إلى إدراك وهو معكم أين ما كنتم وقيل
ولا معنى لشكوى الشوق يوما ... إلى من لا يزول عن العيان
اختلف الناس في الشوق والمحبة أيهما أعلى فقالت طائفة المحبة أعلى من الشوق هذا قول ابن عطاء الله وغيره واحتجوا بأن الشوق غايته أن يكون أثرا من آثار المحبة ومتولدا عنها فهي أصله وهو فرعها قالوا والمحبة توجب آثارا كثيرة فمن آثارها الشوق وقالت طائفة منهم سري السقطي وغيره الشوق أعلى قال الجنيد سمعت السري يقوله الشوق
أجل مقامات العارف إذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه وإنما يظهر سر المسألة بذكر فصلين الأول في حقيقةالشوق والثاني في الفرق بينه وبين المحبة ويتبع ذلك خمس مسائل إحداها هل يجوز إطلاقه على الله كما يطلق عليه أنه يحب عباده أم لا الثانية هل يجوز إطلاقه على العبد فيقال يشتاق إلى الله كما يقال يحبه الثالثة أنه هل يقوى بالوصول والقرب أم يضعف بهما فأي الشوقين أعلى شوق القريب الداني أم شوق البعيد الطالب الرابعة ما الفرق بينه وبين الاشتياق فهل هما بيمعنى واحد أم بينهما فرق الخامسة في بيان مراتبه وأقسامها ومنازل أهله فيه
الفصل الأول في حقيقة الشوق هو سف القلب في طلب محبوبه بحيث لا يقر قراره حتى يطفر به ويحصل له وقيل هو لهيب ينشأ بين أثناءالحشا سببه الفرقة فإذا قع اللقاء أطفأ ذلك اللهيب وقيل الشوق هبوب القلب إلى محبوب غائب وقال ابن خفيف الشوق ارتياح القلوب نحو المحبوب من غير منازع ويقال الشوق انتظار اللقاء بعد البعاد فهذه الحدود ونحوها مشتركة في أن الشوق إنما يكون مع الغيبة من المحبوب وأما مع حضوره ولقائه فلا شوق وهذه حجة من جعل المحبة أعلى منه فإن المحبة لا تزول باللقاء وبهذا يتبين الكلام في الفصل الثاني وهو الفرق بينه وبين المحبة
الفصل الثاني الفرق بينهما فرق ما بين الشيء وأثره فإن الحامل علىالشوق هو المحبة ولهذا يقال لمحبتي له اشتقت إليه وأحببته فاشتقت إلى لقائه ولا يقال لشوقي إليه أحببته ولا اشتقت إلى لقائه فأحببته فالمحبة بذر في القلب والشوق بعض ثمرات ذلك البذر وكذلك من ثمراتها حمد المحبوب والرضى عنه وشكره وخوفه ورجاؤه والتنعم بذكره والسكون والأنس به والوحشة بغيره وكل هذه من أحكام المحبة وثمراتها وهو حياتها فمنزلة الشوق من المحبة منزلة الهرب من البغضاء والكراهة
فإن القلب إذا أبغض الشيء وكرهه جد في الهرب منه وإذا أحبه جد في الهرب إليه وطلبه فهو حركة القلب في الظفر بمحبوبه ولشدة ارتباط الشوق بالمحبة يقع كل واحد منهما موقع صاحبه ويفهم منه ويعبر عنه
فصل وأما المسائل الخمس فإحداها هل يجوز إطلاقه على الله فهذا مما لم يرد به القرآن ولا السنة بصريح لفظه قال صاحب منازل السائرين وغيره وسبب ذلك أن الشوق إنما يكون لغائب ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة ولهذا السبب عندهم لم يجىء في حق الله ولا في حق العبد وجوزت طائفة إطلاقه كما يطلق عليه سبحانه ورووا في أثر انه يقول طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشوق قالوا وهذا الذي تقتضيه الحقيقة وإن لم يرد به لفظ صريح فالمعنى حق فإن كل محب فهو مشتاق إلى لقاء محبوبه قالوا وأما قولكم إن الشوق إنما يكون إلى الغائب وهو سبحانه لا يغيب عن عبده ولا يغيب العبد عنه فهذا حضور العلم وأما اللقاء والقرب فأمر آخر فالشوق يقع بالاعتبار الثاني وهو قرب الحبيب ولقاؤه والدنو منه وهذا له أجل مضروب لا ينال قبله قال تعالى من كان يرجوا لقاء الله فإن أجل الله لأت قال أبو عثمان الحيري هذا تعزية للمشتاقين معناه إني أعلم أن اشتياقكم إلي غالب وأنا أجلت للقائكم أجلا وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه والصواب أن يقال إطلاقه متوقف على السمع ولم يرد به فلا ينبغي إطلاقه وهذا كلفظ العشق أيضا فإنه لما لم يرد به سمع فإنه يمتنع إطلاقه عليه سبحانه واللفظ الذي اطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا وأجل شأنا هو لفظ المحبة فإنه سبحانه يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها فيوصف من الإرادة بأكملها وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته كما قال تعالى فعال
لما يريد وبإرادة اليسر لا العسر كما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وبإرادة الإحسان وإتمام النعمة على عباده كقوله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فإرادة التوبة لله وإرادة الميل لمبتغي الشهوات وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وكذلك الكلام يصف نفسه منه بأعلى أنواعه كالصدق والعدل والحق وكذلك الفعل يصف نفسه منه بأكمله وهو العدل والحكمة والمصلحة والنعمة وهكذا المحبة وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفها فقال يحبهم ويحبونه يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب المحسنين و يحب الصابرين ولم يصف نفسه بغيرها من العلاقة والميل والصبابة والعشق والغرام ونحوها فإن مسمى المحبة أشرف وأكمل من هذه المسميات فجاء في حقه إطلاقه دونها وهذه المسميات لا تنفك عن لوازم ومعان تنزه تعالى عن الاتصاف بها وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكمل معنى ولفظا مما لم يطلقه فالعليم الخبير أكمل من الفقيه والعارف والكريم الجواد أكمل من السخي والخالق البارىء المصور أكمل من الصانع الفاعل
ولهذا لم تجىء هذه في أسمائه الحسنى والرحيم والرؤوف أكمل من الشفيق فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه مالم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته وحينذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح به وغيره فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا وهذا كلفظ الفاعل والصانع فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقا مقيدا أطلقه على نفسه كقوله تعالى فعال لما يريد ويفعل الله ما يشاء وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم ولهذا المعنى والله أعلم لم يجىء في الأسماء الحسنى المريد كما جاء فيها السميع البصير ولا المتكلم ولا لآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء بل وصسف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في إشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا فأدخله في أسمائه الحسنى فاشتق له اسم الماكر والخادع والفاتن والمضل والكاتب ونحوها من قوله ويمكر الله ومن قوله وهو خادعهم ومن قوله لنفتنهم فيه ومن قوله يضل من يشاء وقوله تعالى كتب الله
لأغلبن وهذا خطأ من وجوه أحدها أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء فإطلاقها عليه لا يجوز الثاني أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة فلا يجوز أن ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق الثالث أن مسمى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به وإلى ما يذم فيحسن في موضع ويقبح في موضع فيمتنع إظلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل الرابع أن هذه ليست من الأسماء الحسنى الذي يسمى بها سبحانه كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى وهي التي يحب سبحانه أن يثني عليه ويحمد بها دون غيرها الخامس أن هذا القائل لو سمي بهذه الأسماء وقيل له هذه مدحتك وثناء عليك فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحة ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علوا كبيرا السادس أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائي والآتي والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل والمدمدم والمدمر وأضعاف ذلك فيشتق له اسما من فعل أخبر به عن نفسه إلا تناقض تناقضا بينا ولا أحد من العقلاء طرد ذلك فعلم بطلان قوله والحمد لله رب العالمين
فصل وأما المسألة الثانية وهي هل يطلق على العبد أنه يشتاق إلى الله وإلى لقائه فهذا غير ممتنع فقد روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي وغيرهما من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فقلت خففت يا أبا اليقظان فقال وما علي من ذلك ولقد دعوت الله بدعوات سمعتها من رسول الله فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين فهذا فيه إثبات لذة النظر إلى وجهه الكريم وشوق أحبابه إلى لقائه فإن حقيقة الشوق إليه هو الشوق إلى لقائه قال أبو القاسم القشيري سمعت الأستاذ أبا علي يقول في لقائه أسألك الشوق إلى لقائك قال كان الشوق مائة جزء فتسعة وتسعون له وجزء متفرق في الناس فأراد أن يكون ذلك الجزء له أيضا فغار أن تكون شظية من الشوق في غيره قال وسمعته يقول في قول موسى وعجلت إليك رب لترضى قال معناه شوقا إليك فستره بلفظ الرضى وهذا أكثر مشايخ الطريق يطلقونه ولا يمتنعون منه وقيل إن شعيبا بكى حتى عمي بصره فأوحى الله إليه إن كان هذا لأجل الجنة فقد أبحتها لك وإن كان لأجل النار فقد أجرتك منها فقال لا بل شوقا إليك وقال بعض العارفين من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء وقال بعضهم قلوب العاشقين
منورة بنور الله فإذا تحرك اشتياقهم أضاء النور ما بين السماء والأرض فيعرضهم الله على الملائكة فيقول هؤلاء المشتاقون إلي أشهدكم أني إليهم أشوق وإذا كان الشوق هو سفر القلب في طلب محبوبه ونزوعه إليه فهو من أشرف مقامات العبيد وأجلها وأعلاها ومن أنكر شوق العبد إلى ربه فقد أنكر محبته له لأن المحبة تستلذ الشوق فالمحب دائما مشتاق إلى لقاء محبوبه لا يهدأ قلبه ولا يقر قراره إلا بالوصول إليه
فأما قوله إن الشوق عند الخواص علة عظيمة لأن الشوق إنما يكون إلى غائب ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة فيقال المشاهدة نوعان مشاهدة عرفان ومشاهدة عيان وبينهما من التفاوت ما بين اليقين والعيان ولا ريب أن مشاهدة العرفان متفاوتة بحسب تفاوت الناس بالمعرفة ورسوخهم فيها وليس للمعرفة نهاية تنتهي إليها بحيث إذا وصل إليها العارف سكن قلبه عن الطلب بل كلما وصل منها إلى معلم ومنزلة اشتد شوقه إلى ما وراءه وكلما ازداد معرفة ازداد شوقا فشوق العارف أعظم الشوق فلا يزال في مزيد من الشوق ما دام في مزيد من المعرفة فكيف يكون الشوق عنده علة عظيمة هذا من المحال البين بل من عرف الله اشتاق إليه وإذا كانت المعرفة لا نهاية لها فشوق العارف لا نهاية له هذا مع الشوق الناشىء عن طلب اللقاء والرؤية والمعرفة العيانية فإذا كان القلب حاضرا عند ربه وهو غير غائب عنه لم يوجب له هذا أن لا يكون مشتاقا إلى لقائه ورؤيته بل هذا يكون أتم لشوقه وأعظم فظهر أن قوله وإن الشوق علة عظيمة في طريق الخواص كلام باطل على كل تقدير وإن الشوق بالحقيقة إنما هو شوق الخواص العارفين بالله والعبد إذا كان له مع الله حال أو مقام وكشف له عما هو أفضل منه وأجل اشتاق إليه بالضرورة ولم يكن شوقه علة له ونقصا في حاله بل زيادة وكمالا ويكون ترك الشوق هو العلة وقد تقدم أن لا غاية للمعرفة تنتهي إليها
فيبطل الشوق بنهايتها بل لا يزال العارف في مزيد من معرفته وشوقه والله المستعان
فصل وأما المسألة الثالثة وهي هل يزول الشوق باللقاء أم يقوى فقالت طائفة الشوق يزول باللقاء لأنه طلب فإذا حصل المطلوب زال الطلب لأن تحصيل الحاصل محال ولا معنى للشوق إلى شيء حاصل وإنما يكون الشوق إلى شيء مراد الحصول محبوب الإدراك وقالت طائفة أخرى ليس كذلك بل الشوق يزيد بالوصول واللقاء ويتضاعف بالدنو ولهذا قال القائل
وأعظم ما يكون الشوق يوما ... إذ دنت الديار من الديار
ولهذا قال بعضهم شوق أهل القرب أتم من شوق المحبوبين واحتجت هذه الطائفة بأن الشوق من آثار الحب ولوازمه فكما أن الحب لا يزول باللقاء فهكذا الشوق الذي لا يفارقه قالوا ولهذا لا يزول الرضى والحمد والإجلال والمهابة التي هي من آثار المحبة باللقاء فهكذا الشوق يتضاعف ولا يزول والقولان حق وفصل الخطاب في المسألة أن المحب إذا اشتاق إلى لقاء محبوبه فإذا حصل له اللقاء زال ذلك الشوق الذي كان متعلقا بلقائه وخلفه شوق آخر أعظم منه وأبلغ إلى ما يزيد قربه والحظوة عنده وأما إذا قدر أنه لقيه ثم احتجب عنه ازداد شوقه إلى لقاء آخر ولا يزال يحصل له الشوق كلما احتجب عنه فهذا لا ينقطع شوقه أبدا فهو إذا رآه بل شوقه برؤيته وإذا زال عنه الطرف عاوده الشوق كما قيل
ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته ... حتى يعود إليه الطرف مشتاقا
وإنما الشأن في دوام الشوق حال الوصول واللقاء فاعلم أن الشوق نوعان شوق إلى اللقاء فهذا يزول باللقاء وشوق في حال اللقاء وهو تعلق الروح بالمحبوب تعلقا لا ينقطع أبدا فلا تزال الروح مشتاقة إلى مزيد
من هذا التعلق وقوته اشتياقا لا يهدأ وقد أفصح بعض المحبين للمخلوق عن هذاالمعنى بقوله
أعانقها والنفس بعد مشوقة ... إليها وهل بعد العناق تدان
وألثم فاها كي تزول صبابتي ... فيشتد ما ألقى من الهيمان
فالشوق في حال الوصل والقرب إلى مزيد من النعيم واللذة لا ينقطع والشوق في حال السير إلى اللقاء ينقطع ونستغفر الله من الكلام فيما لسنا بأهل له
فالخوف أولى بالمسي ... ء إذا تأله والحزن
والحب يجمل بالتقى ... وبالبقاء من الدرن
لكن إذا ما لم يحب ... بكم المسيء إذن فمن
وإذا تخون فعلنا ... فعل المحبة مؤتمن
أيحب شيء غيركم ... وحياتكم كلا ولن
أيحب من تأتي محب ... ته بأنواع المحن
والسعد فيها ذابح ... والقلب فيها ممتحن
دون الذي في حبه ... نيل السعادة والمنن
ومحل بدر كمالها ... سعد السعود هو الوطن
والقلب حين يحل في ... تلك المنازل والدمن
يمسي ويصبح من رضا ... ه ومن مناه في وطن
أيحبهم قلب ويخ ... شىأن يضام فلا إذن
فصل وأما المسألة الرابعة وهي الفرق بين الشوق والاشتياق فقال أبو عبدالرحمن السلمي سمعت النصر أباذي يقول للخلق كلهم مقام بن الشوق وليس لهم مقام الاشتياق ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له أثر ولا قرار وهذا يدل على أن الاشتياق عنده غير الشوق
ولا ريب أن الاشتياق مصدر اشتاق يشتاق اشتياقا كما أن التشوق مصدر تشوق تشوقا والشوق في الأصل إسم مصدر شاقة يشوقه شوقا مثل شاقه شوقا إذا دعاه إلى الاشتياق فالاشتياق مطاوع شاقة يقال شاقني فاشتقت إليه ثم صار الشوق اسم مصدر الاشتياق وغلب عليه حتى لا يفهم عند الإطلاق إلا الاشتياق القائم بالمشوق والمشوق هو الصب المشتاق والشائق هو الذي قام به وادعى الشوق فههنا ألفاظ الشوق والاشتياق والتشوق والشائق والمشوق والشيق فهذه ستة ألفاظ أحدها الشوق وهو في الأصل مصدر الفعل المتعدي شاقة يشوقه ثم صار اسم مصدر الاشتياق اللفظ الثاني الاشتياق وهو مصدر اشتاق اشتياقا والفرق بينه وبين الشوق هو الفرق بين المصدر واسم المصدراللفظ الثالث التشوق وهو مصدر تشوق إذا اشتاق مرة بعد مرة كما يقال تجرع وتعلم وتفهم وهذا البناء مشعر بالتكلف وتناول الشيء على مهلةاللفظ الرابع الشائق وهو الداعي للمشوق إلى الاشتياق اللفظ الخامس المشوق وهو المشتاق الذي قد حصل له الشوق اللفظ السادس الشيق وهو فيعل بمنزلة هين ولين وهو المشتاق فهذه فروق ما بين هذه الألفاظ وأما كون الاشتياق أبلغ من الشوق فهذا قد يقال فيه إنه الأصل وهو أكثر حروفا من الشوق وهو يدل على المصدر الفاعل وأما المشوق ففرع عليه لأنه اسم مصدر وأقل حروفا وهو إنما يدل على المصدر المجرد فهذه ثلاثة فروق منها والله أعلم
فصل وأما المسألة الخامسة وهي في مراتب الشوق ومنازله فقال صاحب منازل السائرين وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى شوق العابد إلى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل والدرجة الثانية شوق إلى الله سبحانه وتعالى زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن تعلق قلبه بصفاته المقدسية واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره
وعلامة فضله وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقارنه الاصطبار والدرجة الثالثة نار أضرمها صفو المحبة فنغصت العيش وسلبت السلو ولم ينهنهها مقر دون اللقاء قلت الدرجة الأولى هي شوق إلى فضل الله وثوابه والثانية شوق إلى لقائه ورؤيته والثالثة شوق إليه لا لعلة ولا لسبب ولا ملاحظة فيه غير ذاته فالأول حظ المشتاق من إفضاله وإنعامه والثاني حظه من لقائه ورؤيته والثالث قد فنيت فيه الحظوظ واضمحلت فيه الأقسام
وقوله في الدرجة الأولى ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل هذه ثلاثة فوائد ذكرها في هذا الشوق أمن الخائف وفرح الحزين والظفر بالأمل فهذه المقاصد لما كانت حاصلة بدخول الجنة كانت مصورة للنفس أشد الشوق إلى حصول هذه المطالب وهي الفوز والفرح وجماع ذلك أمران أحدهما النجاة من كل مكروه والثاني الظفر بكل محبوب فهذان هما المشوقان إلى الجنة
وقوله في الثانية شوق إلى الله سبحانه وتعالى زرعه الحب قد تقدم أن الشوق ثمرة الحب وقوله الذي ينبت على حافات المنن أي انشأه الفكر في منن الله وأياديه وأنعامه المتواترة وفيه إشارة إلى أن هذا الحب الذي هو نابت على الحافات والجوانب بعده حب أكمل منه وهو الحب الناشىء من شهود كمال الأسماء والصفات وذلك ليس من نبات الحافت ولكن من الحب الأول يدخل في هذا كما تقدم ولهذا قال تعلق قلبه بصفاته المقدسة وقوله واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وعلامة فضله يشير به غلى ما يكرم الله به عبده من أنواع كراماته التي يستدل بها على أنه مقبول عند ربه ملاحظ بعنايته وأنه قد استخدمه وكتبه في ديوان
أوليائه وخواصه ولا ريب أن العبد متى شاهد تلك العلامات والآيات قوي قلبه وفرح بفضل ربه وعلم أنه أهل فطاب له السير ودام اشتياقه وزالت عنه العلل وما لم ينعم عليه بشيء من ذلك لم يزل كئيبا حزينا خائفا أن يكون ممن لا يصلح لذلك الجناب ولم يصل لتلك المنزلة وقوله وهذا شوق تغشاه المبار هي جمع مبرة وهي البر أي أن هذا الشوق مشحون بالبر مغشي به وهو إما بر القلب وهو كثرة خيره فهذا القلب أكثر القلوب خيرا فيفعل البر تقربا إلى من هو مشتاق إليه فهو يجيش بأنواع البر وهذه من فوائد المحبة أن قلب صاحبها ينبع منه عيون الخير وتنفجر منه ينابيع البر يريد به أن مبار الله ونعمه تغشاه على الدوام وقوله وتخالجه المسار يخالطه السرور في غضون أشواقه فإنها أشواق لا وحشة معها ولا ألم بل هي محشوة بالمسرات وقوله ويقارنه الاصطبار أي صحابه له قوة على اصطباره على مرضاة حبيبه لشوقه إليه وإنما يضعف الصبر لضعف المحبة والمحب من أصبر الخلق كما قيل
نفس المحب على الآلام صابرة ... لعل مسقمها يوما يداويها
وقوله في الدرجة الثالثة إنها نار أضرمها صفو المحبة يعني أن هذا الشوق يتوقد من خالص المحبة التي لا تشوبها علة فهو أشد أنواع الشوق ولهذا نغصت العيش أي كدرته ونغصت المشتاق فيه لأنه لا يصل إلى محبوبه ما دام فيه فهو يترقب مفارقته وقوله وسلبت السلو يعني أن صاحبه لم يبق له مطمع في سلوه أبدا وهذا أعظم ما يكون من الحب والشوق أن المحب آيس من السلو وانتقطع طمعه منه كما أيس من الأمور الممتنعة كرجوع أيام الشباب عليه وعوده طفلا ونحو ذلك وقوله ولم ينهنهها مقر دون اللقاء أي أن هذه النار لا يبردها ولا يفتر حرها مقصود ولا مطلب ولا مراد دون لقاء محبوبه فليس لا سبيل إلى تبريدها وتسكينها إلا بلقاء محبوبه
فصل قال أبو العباس فهذه كلها علل أنف الخواص منها وأسباب النفطموا عنها فلم يبق لهم مع الحق إرادة ولا في عطائه تشوق إلى استزادة فهو منتهى زادهم وغاية رغبتهم فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله وإنما زهدهم جمع الهمة عن تعرفات الكون لأن الحق عافاهم بنور الكشف يعن التعلق بالأحوال إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار قلت يشير بذلك إلى المحو ومقام الفناء الذي هو غاية الغايات عنده وقد تقدم الكلام عليه وأن مقام الصحو والبقاء أفضل منه وأتم عبودية وينبغي أن يعرف أن مراعاة مقام الفناء الذي جعلوه غاية آل بكثير من طالبيه إلى ترك القيام بالأعمال جملة ورأوا أنها علل قاطعة عنه واشتد نكير الشيوخ والأئمة عليهم حتى قال شيخ الطائفة الجنيد إن الذي يزني ويسرق خير من هؤلاء وهم نوعان نوع جردوا الفناء في شهود الحكم وهو الحكم القدري ورأوا أنه نهاية التوحيد فآل بهم استغراقهم فيه إلى اطراح الأسباب حتى قال قائلهم العارف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر والنوع الثاني أصحاب تجريد الفناء والإرادة فجردوا الفناء والإرادة تجريدا آل بهم إلى ترك الأسباب جملة والطائفتان منحرفتان ضالتان خارجتان عن العلم والدين ولهذا قال لهم شيخ القوم الجنيد عليكم بالفرق الثاني يعني أن الفرق فرقان فرق بالطبع والهوى وهو الفرق الذي شهدوه وفروا منه إلى معنى الجمع ولكن بعد الجمع فرق ثان وهو الفرق بالأمر والمحبة لا بالشهوة والطبع وهو دين الرسل فإن دينهم مبناه على الفرق الأمري الشرعي بين محبوب الرب ومأموره وبين مسخوطه ومنهيه فمن لم يشهد هذا الفرق ولم يكن من أهله لم يكن من
أتباع الرسل فإن الكمال شهود الجمع في هذا الفرق فيشهد انفراد الله وحده بالخلق والأمر ويشهد الفرق بين ما يحبه فيؤثره ويقدمه وبين ما بيبغضه فيتركه ويتجنبه فيصير له هذا الفرق في محل فرقه الطبعي الحسي بين ما يلائمه وينافره ومن المعلوم أن صاحب الجمع لا بد أن يفرق بطبعه وحسه وإن ادعى عدم التفريقب طبعا فإنه كاذب مفتر وإذا كان لا بد من الفرق فالفرق الشرعي الإيماني الذي بعث الله به رسله أولى به من الفرق الطبعي الحيواني الذي شاركه فيه سائر البهائم وأبطل من هذا الجمع الجمع في الوجود وهو أن يرى الوجود كله واحدا لا فرق فيه أصلا وإنما التفريق بالعادة والوهم فقط كما يقوله زنادقة القائلين بوحدة الوجود الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود أحدهما وجود الآخر بل ليس عندهم فرق بين أحدهما والآخر إذ ما ثم غير فهذا جمع في الوجود وجمع أولئك جمع في الشهود فهدى الله الذين ءامنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فكانوا أصحاب الجمع في الفرق ففرقوا بين ما فرق الله بينه بإذنه وجمعوا الأشياء كلها في خلقه وأمره وجمعوا إرادتهم ومحبتهم وشهودهم فيه فكانوا أصحاب جمع في فرق وفرق في جمع فهؤلاء خواص الخلق فنسأل الله العظيم من فضله وكرمه أن يجعلنا منهم فهؤلاء هم الذين لم يبق لهم مع الحق إرادة بل صارت إرادتهم تابعة لإرادته فحصل الاتحاد في المراد فقط لا في الإرادة ولا في المريد فأصحاب الوحدة ظنوا الاتحاد في المريد وأصحاب الحلول توهموا الاتحاد في بالإرادة فهدى الله الذين ءامنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فعلموا أن المراد واحد فالاتحاد وقع في المراد فقط لا في الإرادة ولا في المريد وقوله فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه إنما يكون ما دونه قاطعا عنه إذا وقف العبد معه وتعلقت إرادته به وانصرف طلبه إليه وأما إذا جعله وسيلة إلى الله
وطريقا يصل بها إليه لم يكن قاطعا ولا حجابا بل يكون حاجبا موصلا إليه وقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم المراد بالآية شهادته سبحانه لرسوله بتصديقه على رسالته فإن المشركين قالوا لرسول الله من يشهد لك على ما تقول فأنزل الله سبحانه آيات شهادته له وشهادة ملائكته وشهادة علماء أهل الكتاب به فقال تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أي ومن عنده علم الكتاب يشهد لي وشهادته مقبوله لأنها شهادة بعلم قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى
بالله شهيدا وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم فأخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته لرسوله وكفى بشهادته إثباتا لصدقه وكفى به شهيدا فإن قيل وما شهادته لرسوله قيل هي ما أقام على صدقه من الدلالات والآيات المستلزمه لصدقه بعد العلم بها ضرورة فدلالتها على صدقه أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على حق فشهادته سبحانه لرسوله أصدق شهادة وأعظمها وأدلها على ثبوت المشهود به فهذا وجه ووجه آخر أنه صدقه بقوله وأقام الأدلة القاطعة على صدقه فيما يخبر به عنه فإذا أخبر عنه أنه شهد له قولا لزم ضرورة صدقه في ذلك الخبر وصحت الشهادة له به قطعا فهذا معنى الآية وكان أجنبيا عما استدل به المصنف
ونظير هذا استشهادهم بقوله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا ءاباؤكم قل الله ثم ذرهم حتى رتب على ذلك بعضهم أن الذكر بالاسم المفرد وهو الله الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا فاسد مبني على فاسد فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا ولا مفيد شيئا ولا هو كلام أصلا ولا يدل على مدح ولا تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة فلو قال الكافر الله الله من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلما فضلا عن أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالأسم الظاهر فالذكر بقوله هو هو بالاسم المضمر أفضل من الذكر بقولهم الله الله
وكل هذا من أنواع الهوس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات فهذا فساد هذا البناء الهائر وأما فساد المبني عليه فإنهم ظنوا أن قوله تعالى قل الله أي قل هذا الاسم فقل الله الله وهذا من عدم فهم القوم لكتاب الله فإن اسم الله هنا جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا إلى أن قال قل الله أي قل الله أنزله فإن السؤال معاد في الجواب فيتضمنه فيحذف اختصارا كما يقول من خلق السموات والأرض فيقال الله أي الله خلقهما فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه فهذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره
قوله وإنما زهدهم جمع الهمة عن تعريفات الكون لأن الحق عافاهم بنور الكشف عن التعلق بالأحوال فيقال الكشف الذي أوجب لهم هذا الجمع وقطع هذا التعلق هو الكشف الإيماني القرآني فهو في الحقيقة الكشف النافع الجاذب لصاحبه إلى سلوك منازل الأبرار والوصول إلى مقامات القرب ولا سيما إذا قارنه الكشف عن عيوب النفس وعلى الأعمال فناهيك به من كشف والكرامة المرتبة عليه هي لزوم الاستقامة ودوام العبودية فهذا أفضل كشف يعطاه العبد وهذه أفضل كرامة يكرم بها الولي رزقنا الله من فضله وبره وأما استشهاده بقوله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار فهذه الآية يخبر فيها سبحانه عما أخلص له أنبياؤه ورسله من ختصاصهم بالآخرة وفيها قولان أحدهما أن المعنى نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل بها والقول الثاني إنا أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة واختصصناهم به عن العالمين
قوله وتوكلهم رضاهم بتدبير الحق وتخلصهم من تدبيرهم وفراغ همهم من احتيالها فلي إصلاح شؤونها بوقوفهم على فراغ المدبر منها ومرها على علمه بمصالحهم فيها ونفوسهم مطمئنة بذلك يا أيتها النفس المطمئنة الآية وقد تقدم الكلام على التوكل وبيان أنه من مقامات العارفين وأنه لا انفكاك للمؤمن منه وذكر العلة فيه ما هي وقوله وتوكلهم رضاهم بتدبير الحق الرضا بالتدبير ثمرة التوكل وموجبه لا أنه نفس التوكل والمقدور يكشفه أمران التوكل قبل وقوعه والرضا به بعد وقوعه ومن هنا قال بعضهم حقيقة التوكل الرضا لأنه لما كان ثمرته وموجبه استدل له عليه استدلالا بالأثر على المؤثر وبالمعلول على العلة ولهذا قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي أنه قال في دعائه اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك علىالخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت الحديث وقد تقدم فقال وأسألك الرضا بعد القضاء وأما التوكل فإنما يكون قبله وقوله وتخلصهم من تدبيرهم هذا مقام كثيرا ما يشير إليه السالكون وهو ترك التدبير وينبغي أن لا يؤخذ على إطلاقه بل لا بد فيه من التفصيل فيقال العبد دائر بين مأمور يفعله ومحظور يتركه وقد يجري عليه بلا إرادة منه ولا كسب فوظيفته في المأمور كمال التدبير والجد
والتشمير وأن يدبر الحيلة في تنفيذه بكل ما يمكنه فترك التدبير هنا تعطيل للأمر بل يدبر فعله ناظرا إلى تدبير الحق له وأن تدبيره إنما يتم بتدبير الله له فلا يكون هنا قدريا مجوسيا ناظرا إلى فعله جاحدا لتدبير الله وتقديره ومعونته ولا قدريا مجبرا ولا واقفا مع القدر جاحدا لفعله وتدبيره ومجلى أمر الله ونهيه فإن فعله الاختياري هو محل الأمر والنهي فمن جحد فعل نفسه فقد عطل الأمر والنهي وجحد محلهما ووظيفته في المحظور الفناء عن إرادته وفعله فإن عارضته أسباب الفعل فالواجب عليه الجد في الهرب والتشمير في الكف والبعد وهذا تدبير للنهي وأما القدر الذي يصيبه بغير إرادته فهذا الذي يحسن فيه إسقاط التدبير جملة وصبره ورضاه بما قسم له من محبوب ومكروه فعلى هذا التفصيل ينبغي أن يوضع إيقاط التدبير وجماع ذلك أنك تسقط التدبير في حظك وتكون قائما بالتدبير في حق ربك وهكذا ينبغي أن تفرغ الهمة من إجالتها في إصلاح شأنك فإن إصلاح شأنك بحصول حظوظك يحصل فيه فراغ الهمة وترك التدبير وأما أصلاح شأنك بأداء حق الله فالواجب شغل الهمة وإجالتها في القيام به وقوله بوقوفهم على الفراغ المدبر منها ومرها على علمه بمصالحهم فيها فلا ريب أن الله سبحانه وتعالى قضى القضية وفرغ من تدبير أمور الخلائق ولكن قدرها بأسبابها المفضية إليها فلا يكون وقوف العبد على فراغه سبحانه وتعالى من أقضيته في خلقه وتدبيره مانعا له من قيامه بالأسباب التي جعلها طرقا لحصول ما قضاه منها وكذلك يباشر العبد الأسباب التى بها حفظ حياته من الطعام والشراب واللباس والمسكن ولا يكون وقوفه مع فراغ المدبر منها مانعا له من تعاطيها وكذلك يباشر الأسباب الموجبة لبقاء النوع من النكاح والتسري ولا يكون وقوفه مع فراغ الله من خلقه مانعا له وهكذا جميع مصالح الدنيا والآخرة وإن كانت مفروغا منها قضاء وقدرا فهي منوطة بأسبابها التي يتوقف حصولها عليها شرا وخلقا وأما استدلاله بقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنت إلى ربها وسكنت إلى حبه واطمأنت بذكره وأيقنت بوعده ورضيت بقضائه وهي ضد النفس الأمارة بالسوء فلم تكن طمأنينتها بمجرد إسقاط تدبيرها بل القيام بحقه والطمأنينة بحبه وبذكره
فصل قال وصبرهم صونهم قلبوهم عن خاطر السوء أن الله قضى قضاء عاريا عن الموافقة خارجا عن الخيرة قال الله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا قد تقدم الكلام في الصبر وأقسامه وبيان مرتبته من الإيمان وما ذكره في تفسيره ههنا غير مطابق لمعناه وهو تفسير بعيد جدا فإن الصبر من أعمال القلوب وهو حبس النفس وكفها عن السخط وأما صون القلب عن اعتقاد مالا يليق بالله فلا يقال له صبر بل هذا من لوازم الإيمان وهو كاعتقاد أنه سبحانه وتعالى حكيم رحيم عليم سميع بصير إلى غير ذلك من صفات كماله فلا يقال الصبر صون القلب عن اعتقاد أضدادها هذا بعيد جدا وتكلف زائد لتفسير الصبر وهل فهم أحد قط هذا المعنى من قوله تعالى يا أيها الذين ءامنوا اصبروا وصابروا وقوله تعالى والصبر لحكم ربك وقوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله وقوله فاصبر على ما يقولون واصبروا إن الله مع الصابرين وسائر نصوص الصبر ومن العجب جعل الصبر الذي هو
نصف الإيمان من منازل العوام وتفسيره بهذا التفسير نعم يجب على كل مسلم أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يقضي قضاء ينافي حكمته وعدله وفضله وبره وإحسانه بل كل أقضيته لا تخرج عن الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة وإن كان كثير من المتكلمين ينازع في هذا الأصل ويقول الذي ينزه الله عنه من الأقضية هو المستحيل الممتنع وأما الممكن فلا يقبح منه شيء وهؤلاء لا يمكن صون القلب عن خواطر السوء المتعلقة بما يقضيه الله عندهم إلا صونها عن خواطر الممتنعات والمستحيلات فقط وبالجملة هذا مقام آخر غير مقام الصبر بل هذا باب من أبواب المعرفة والعلم ولكل مقام مقال وأما استشهاده بقوله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا فالبلاء الحسن هنا هو النعمة بالظفر والغنيمة والنصر على الأعداء وليس من الابتلاء الذي هو الامتحان بالمكروه بل من أبلاه بلاء حسنا إذا أنعم عليه يقال أبلاك الله ولا ابتلاك فأبلاه بالخير وابتلاه بالمكاره غالبا كما في الحديث إني مبتليك ومبتل بك
فصل قال وحزنهم يأسهم عن أنفسهم الأمارة بالسوء إن الإنسان لربه لكنود وقد تقدم أيضا الكلام على ما ذكره في الحزن وأما تفسيره إياه أنه بأسهم عن أنفسهم الأمارة بالسوء فليس بالبين فإن الحزن هو الأسف على فوت محبوب أو حصول مكروه وإن تعلق ذلك بالماضي كان حزنا وإن تعلق بالمستقبل كان خوفا وهما وأما اليأس عن النفس الأمارة بالسوء فليس بحزن ويمكن أن يكون مراده أن حزنهم ينشأ عن النفس الأمارة بالسوء لا عن المطمئنة فإن المطمئنة لا تحزن وإنما تحزن الأمارة
لفوات محبوبها وليس هذا كما قال فإن النفس المطمئنة تحزن على تقصيرها في أداء الحق وعلى تضييعها الوقت وإيثارها غير الله عليه في الأحيان وهذا الحزن لا بد منه إذ التقصير ! والتضييع لازم وأما استشهاده على ذلك بقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود فوجهه أن الكنود هو الكفور وهو الذي يذكر المصائب وينسي النعم ولا ريب أن الحزن ينشأ عن هذين ولا ريب أن الحزن الناشىء عن الكنود حزن ناشىء عن النفس الأمارة بالسوء وأما الحزن على تقصيره وتضييع وقته فليس من هذا وقد تقدم ذلك وذكر أقسام الحزن ومتعلقاته والله أعلم
فصل قال وخوفهم هيبة الجلال لا خوف العذاب فإن خوفهم مناضلة عن النفس وضن بها وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس يخافون ربهم من فوقهم وقال في حق العوام يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقد تقدم أيضا الكلام على ما ذكره في الحديث وعلته وقوله هو هيبة الجلال لا خوف العذاب تقدم بيان بطلانه وأن الله سبحانه أثنى على خاصة أوليائه من الملائكة والأنبياء وغيرهم ممن عبدهم المشركون بأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف يقال إن خوف العذاب نقص ومناضلة عن النفس هذا من الترهات والزعوم ودعاوي الأنفس وقوله إن الخوف مناضلة عن النفس فسبحان الله هل يقال لمن خاف الله وخاف عقوبته إنه مناضل ربه ولو كان مناضله فهو مناضلة العدو والهوى والشهوة وهذه المناضلة من أعظم أنواع العبودية فإن من خاف شيئا ناضل عنه فهو مناضلة عن العذاب
وأسبابه وما ثم إلا مناضلة وإلقاء باليد إلى التهلكة ولولا هذه المناضلة لحصل الاستسلام للعقوبة والمناضلة المحذورة المناضلة عن محبوبات الرب وأوامره وليس الضن بالنفس عن عذاب الله نقصا بل الكمال والفوز والنعيم في ضن العبد بنفسه عن أن يسلمها لعذاب الله ومن لم يضن بنفسه فليس فيه خير البتة والضن بالنفس إنما يذم إذا ضن بها عن بذلها في محبوب الرب وأوامره وأما إذا ضن بها عن عذابه فهل يكون هذا علة وهل العلة كلها إلا في عدم هذه المناضلة والضن قوله وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس قد تقدم الكلام في الهيبة والتعظيم وأنهما غير الخوف والخشية ولا تستلزم هذه الهيبة أيضا نسيان النفس ولا يكون شعور العبد بنفسه في هذا المقام نقصا ولا علة كما تقدم بل هو أكمل لاستلزامه البقاء الذي هو أقوى وأكمل من الفناء وأما قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم فهو حجة عليه كما تقدم ولا يصح تفسير الخوف هنا بالهيبة لوجهين أحدهما أنه خروج عن حقيقة اللفظ ووضعه الأصلي بلا موجب الثاني أن هذا وصف للملائكة وقد وصفهم سبحانه بخوفه وخشيته فالخوف في هذه الآية والخشية في قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون فوصفهم بالخشية والإشفاق ووصفهم بخوف العذاب في قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وهم خواص خلقه فإياك ورعونات النفس وحماقاتها وجهالاتها ولا تكن ممن لا يقدر الله حق قدره وقد قال النبي إن الله لو عذب
أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم فإذا علم المقرب العارف أن الله لو عذبه لم يظلمه فمن أحق بالخوف منه قوله وقال في حق العوام ! يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار هذا من الشطحات القبيحة الباطلة فإن هذا صفة خواص عباده وعارفيهم وهم الذين قال فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله فهؤلاء خواص الخلق وهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان أفلا يستحي من جعل هذا الومصف للعوام ولا ريب أن هذا مصدره إما جهل مفرط وإما تقليد لقائل لا يدري لازم قوله هذا إن أحسن الظن بقائله وإن كان مصدره غير ذلك فأدهى وأمر ولولا أن هذه الكلمات ونحوها مهاو ومعاطب في الطريق لكان الإعراض عنها إلى ما هو أهم منها أولى والله المستعان
فصل قال ورجاؤهم ظمؤهم إلى الشراب الذي هم في غرقى وبه سكرى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل وهذا أيضا من ذلك النمط ورجاء الأنبياء والرسل فمن دونهم إنما هو طمعهم في رحمته ومغفرته وانظر إلى دعوى هؤلاء وإلى قول إمام الحنفاء خليل الرحمن والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين كيف علق رجاءه وطمعه بمغفرة الله له قال تعالى عن خاصة خلقه وأعلمهم به أنهم يرجون
رحمته ويخافون عذابه ومن العجب استدلاله بقوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل فما لهذه الآية وما للرجاء ولا سيما ما ذكره المصنف في تفسيره رجاء القوم والاستشهاد بهذا من جنس الألغاز ومعنى الآية التنبيه على هذه الدلالة الباهرة على قدرة الرب سبحانه وعجائب مخلوقاته الدالة عليه والمعنى انظر كيف بسط ربك الظل والظل ما قبل الزوال والفيء بعده فمده سبحانه وبسطه عند طلوع الشمس فإنه يكون مديدا أطول ما يكون وجعل الشمس دليلا عليه فإنها هي التي تظهره وتبينه ثم كلما ارتفعت الشمس شيئا انقبض من الظل جزء فلا يزال ينقص يسيرا حتى ينتهي إلى غايته فإذا أخذت الشمس في الجانب الغربي انبسط بعد انقباضه شيئا فشيئا حتى يصير كهيئته عند طلوعها ولهذا كان الزوال يعرف بانتهاء الظل في قصره فإذا أخذ في الزيادة بعد تناهي قصره فقد تحقق الزوال ولو شاء الله لجعله ساكنا دائما على حالة واحدة فلا يتحرك بالزيادة والنقصان فالظل أحد الأدلة على الخالق سبحانه وأما دلالة هذه الآية على الرجاء فيحتاج إلى أشارة وتكلف غير مقصود بها وآيات الرجاء في القرآن أكثير وأظهر وأصرح في المقصود ظاهرة واستنباطا فالظاهرة كقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء به وقوله تعالى يرجون رحمته وقوله من كان يرجو لقاء الله والمستنبطة كآيات البشارة كلها كقوله وبشر المؤمنين وبشر الصابرين فبشر عباد
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فصل قال وشكرهم وسرورهم بموجودهم واستبشارهم بلقائه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وهذا أيضا من النمط المتقدم وشكر القوم هو عملهم بطاعة الله واستعانتهم بنعمه على محابه قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقال النبي لما قيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا فسمى الأعمال شكرا وأخبر أن شكره قيامه بها ومحافظته عليها فحقيقة الشكر هو الثناء على النعم ومحبته والعمل بطاعته كما قال
أفادتكم النعماء عندي ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحجبا
فاليد للطاعة واللسان للثناء والضمير للحب والتعظيم وأما السرور به وإن كان من أجل المقامات فإن العبد إنما يسر بمن هو أحب الأشياء إليه وعلى قدر حبه له يكون سروره وهذا السور ثمرة الشكر لا أنه نفس الشكر فكذلك الاستبشار والفرح بلقائه إنما هو ثمرة الشكر وموجبه وهو كالرضا من التوكل وكالشوق من المحبة وكالأنس من الذكر وكالخشية من
العلم وكالطمأنينة من اليقين فإنها ثمرات لها وآثار وموجبات فعلى قدر شكره لله بالأعمال الظاهرة والباطنة وتصحيح العبودية يكون سروره واستبشاره بلقائه وأما قوله سبحانه وتعالى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فهذا إنما قاله للشاكين الذين يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون ثم وصفهم بعد ذلك بقيامهم بأعمال الشكر فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله فهؤلاء المستبشرون ببيعهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه
فصل قال ومحبتهم فناؤهم في محبة الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال وقد تقدم الكلام على هذا بما فيه الكفاية وبينا أن البقاء في المحبة أفضل وأكمل من الفناء فيها من وجوه متعددة وأن الفناء إنما هو لضعف المحب عما حمل وأما الأقوياء فهم مع شدة محبتهم في مقام البقاء والتمييز وأما استدلاله بقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فالآية إنما سبقت في الكلام على من يعبد غير الله ويشرك به قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل إفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون فمن عبد غير الله فما عبد إلا الضلال المحض
والباطل البحت وأما من عبد الله بأمره وكان في مقام التمييز بين محابه ومساخطه مفرقا بينهما يحب هذا ويبغض هذا ناظرا بقلبه إلى ربه عاكفا بهمته عليه منفذا لأوامره فهو مع الحق المحض والله أعلم
فصل قال وشوقهم هزمهم من رسمهم وسماتهم استعجالا للوصول إلى غاية المنى وعجلت إليك رب لترضى قد تقدم الكلام في الشوق مستوفى وليس الهرب من الغير والضد هو ال شوق بل هنا مهروب منه ومهروب إليه فالشوق هوسفر القلب نحو المحبوب وهذا لا يتم إلا بالهرب من ضده فليس الشوق هو نفس الهرب من الرسوم والسمات
فصل قال والإرادة والزهد والتوكل والصبر والحزن والخوف والرجاء والشكر والمحبة والشوق من منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة فإذا شاهدوا عين الحقيقة اضمحلت فيها أحوال الشاهدين حتى يفنى ما لم يكن ويبقى ما لم يزل قلت الحقائق التي أشار إليها على لسان أهل السلوك ثلاث حقيقة إيمانية نبوية وهي حقيقة العبودية التي هي كمال الحب وكمال الذل وسير أهل الاستقامة إنما هو إلى هذه الحقيقة ومنازل السير التي ينزلون فيها هي منازل الإيمان المصولة إليها والمنحرفون لا يرضون بهذه الحقيقة ولا يقفون معها ويرونها منزلة من منازل العامة الحقيقة الثانية حقيقة كونية قدرية يشاهدون فيها انفراد الرب سبحانه بالتكوين والإيجاد وحده وأن العالم كالميت يقلبه ويصرفه كيف يشاء وهم يعظمون هذا المشهد ويورون الفناء فيه غاية ما بعيدها شيء وهذا ن أغلاطهم في المعرفة والسلوك فإن هذا المشهد لا يدخل صاحبه في الإيمان فضلا عن أن يكون أفضل مشاهد أولياء الله المقربين فإن عباد
الأصنام شهدوا هذا المشهد ولم ينفعهم وحده قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا وهذا كثير في القرآن فالفناء في هذا المشهد لا يدخل العبد في دائرة الإسلام فكيف يجعله هوم الحقيق ةالتي ينتهي إليها سير السالكين ويجعل حقيقة الإيمان ودعوة الرسل منزلة من منازل العامة وهل هذا إلا غاية الانحراف والبعد عن الصراط المستقيم وقلب للحقائق وكم قد هلك في هذه الحقيقة من أمم لا يحصيهم إلا الله وكم عطل لأجلها الواقفون معها من الشرائع وخربوا من المنازل وما نجا من معاطيها إلا من شملته العناية الربانية ونفذ ببصره من هذه الحقيقة إلى الحقيقة الإيمانية النبوية حقيقة رسل الله وأنبيائه وأتباعهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والحقيقة الثالثة حقيقة اتحادية بل واحدية لا يفرق فيها بين الرب والعبد ولا بين القديم والمحدث ولا بين صانع ومصنوع بل الأمر كله واحد والأمر المخلوق هو عين الأمر الخالق وهذه الحقيقة التي يشير إلى عينها طائفة الاتحادية ويعدون من
لم يكن من أهلها محجوبا وهذه حقيقة كفرية اتحادية وهي مع ذلك خيال فاسد وعقل منكوس وذوق من عين منتنة وكفرأهلها أعظم من كفر كل أمة فإنهم جحدوا الصانع حقا وإن أثبتوه جعلوا وجوده وجود كل موجود والذين أثبتوا الصانع وعدلوا به غيره وسووا بينه وبين غيره في العبادة مقالتهم خير من مقالة هؤلاء الذي جعلوه وجود كل موجود وعين كل شيء تعالى الله عما يقول الكاذبون المفترون علوا كبيرا فعليك بالفرق بين السائرين إلى هذه الحقيقة والسائرين إلى عين الحقيقة الكونية الحكمية
والسائرين إلى عين الحقيقة المحمدية الإبراهيمية الحنيفية التي هي حقيقة جميع الأنبياء والمرسلين وفيها تفاوتت مراتب السالكين ويمنازلهم من القرب من رب العالمين قال شيخ هذه الحقيقة إبراهيم عليه السلام لما تحقق فناء تلك الرسوم وأفولها إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وهذا التوجه يتضمن محبته دون غيره وعبادته وطاعته دون غيره فهذه هي الحقيقة حقا وما سواها باطل حقيقة قال تعالى لأكرم خلقه عليه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فأمره تعالى أن يقتدي بأبيه إبراهيم في هذه الحقيقة وكان يعلم أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنفا مسلما وما كان من المشركين فنسأل الله العظيم أن يهب
لنا هذه الحقيقة ويثبتنا عليها ويعيذنا مما سواها إنه قريب مجيب بمنه وكره والله أعلم
فصل في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها وهم ثمان عشرة طبقة
الطيقة الأولى وهي العليا على الإطلاق مرتبة الرسالة فأكرم الخلق على الله وأخصهم بالزلفى لديه رسله وهم المصطفون من عباده الذين سلم عليهم في العالمين كما قال تعالى وسلام على المرسلين وقال تعالى سلام على نوح في العالمين وقال تعالى سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين سلام على إل ياسين وقال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وكلمة السلام هنا تحتمل أن تكون داخلة في حيز القول فتكون معطوفة على الجملة الخبرية وهي الحمد لله ويكون الأمر بالقول متناولا للجملتين معا وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة الأخيرة ويكون محلها النصب محكيه بالقول ويحتمل أن تكون جملة مستأنفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب وهذا التقدير أرجح وعليه يكون السلام من الله عليهم وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانهوتعالى على رسله عليهم السلام وعلى التقدير الأول يكون أمر بالسلام عليهم ولكن يقال على هذا كيف يعطف الخبر على الطلب مع تنافر ما بينهما فلا يحسن أن يقال قم وذهب زيد ولا أخرج وقعد عمرو أو يجاب على هذا بأن جملة الطلب قد حكيت بجملة خبرية ومع هذا لا يمتنع العطف فيه بالخبر على الجملة الطلبية لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه وهذا نظير قوله تعالى قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فقوله تعالى وما تغني الآيات ليس معطوفا علىالقول وهو نظروا بل معطوف على الجملة الكبرى على أن عطف الخبر على الطلب كثير كقوله تعالى قل رب احكم بالحق وربنبا الرحمن المستعان على ما تصفون وقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والمقصود أنه على هذا القول يكون الله سبحانه وتعالى قد سلم على المصطفين من عباده والرسل أفضلهم وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه أخلصهم بخالصة ذكرى الدار وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بوحيه وجعلهم أمناء على رسالته وواسطة بينه وبين عباده وخصهم بأنواع كراماته فمنهم من اتخذه خليلا ومنهم من كلمه تكليما ومنهم من رفعه مكانا عليا على سائرهم درجات ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم ولا دخولا إلى جنته إلا خلفهم ولم يكرم أحدا منهم بكرامة إلا على أيديهم فهم أقرب الخلق إليه وسيلة
وأرفعهم عنده درجة وأحبهم إليه وأكرمهم عليه وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم وبهم عرف الله وبهم عبد وأطيع بهم حصلت محابه تعالى في الأرض وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم المذكورون في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خاتمهم وأفضلهم
الطبقة الثانية من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم بعضهم على بعض
الطبقة الثالثة الذين لم يرسلوا إلى أممهم وإنما كانت لهم النبوة دون الرسالة فاختصوا عن الأمة بإيحاء الله إليهم وإرساله ملائكته إليهم واختصت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة بدعوتهم إلى الله بشريعته وأمره واشتركوا في الوحي ونزول الملائكة عليهم
الطبقة الرابعة ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طرقهم ومنهاجهم وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة وهي مرتبة الصديقية ولهذا قرنهم الله في كتابه بالأنبياء فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة وهؤلاء هم الربانيون وهم الراسخون في العلم وهم الوسائط بين الرسول وأمته فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه وهم
المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وقال الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وقيل إن الوقف على قوله تعالى هم الصديقون ثم يبتدىء والشهداء عند ربهم فيكون الكلام جملتين أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين هنا وفي سورة النساء وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في كلام النبي في قوله أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل الخلق بعبد الأنبياء والمرسلين أبي بكر الصديق ولو كان بعبد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتا له رضي الله عنه وقيل إن الكلام كله جملة واحدة وأخبر عن المؤمنين بأنهم هم الصديقون والشهداء عند ربهم وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة وهو قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس وهم المؤمنون فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة ويكون الشهداء وصفا لجملة
المؤمنين الصديقين وقيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله وعلى هذا القول يترجح أن يكون الكلام جملتين ويكون قوله والشهداء مبتدأ خبره ما بعده لأنه ليس كل مؤمن صديق شهيدا في سبيل الله ويرجحه أيضا أنه لو كان الشهداء داخلا في جملة الخبر لكان قوله تعالى لهم أجرهم ونورهم داخلا أيضا في جملة الخبر عنهم ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء أحدها أنهم هم الصديقون الثاني أنهم هم الشهداء والثالث أن لهم أجرهم ونورهم وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول ثم ذكر الخبر الثالث مجردا عن العطف وهذا كما تقول زيد كريم وعالم له مال والأحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعا فتقول زيد كريم عالم له مال أو كريم وعالم وله مال فتأمله ويرجحه أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء وهم الصديقون والشهداء والصالحون وهم المذكورون في الآية وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضا حسنا فهؤلاء ثلاثة أصناف ثم ذكر الرسول في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكور في سورة النساء فهؤلاء هم السعداء ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان كفار ومنافقون فقال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وذكر المنافقون في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم فهؤلاء أصناف العالم كلهم وترك سبحانه وتعالى ذكر المخلط صاحب الشائبتين على طريقة القرآن في ذكر السعداء والأشقياء دون المخلطين غالبا لسر اقتضته حكمته فليحذر صاحب التخليط فإنه لا
ضمان له على الله ولا هو من أهل وعده المطلق ولا ييأس من روح الله فإنه ليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعيد كل منهما يدعوه إلى موجبه لأنه أتى بسببه وهذا هو الذي لحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين ولكن غلطوا في تخليده في النار ولو نزلوه منزلة بين المنزلتين ووكلوه إلى المشيئة وقالوا بأنه يخرج من النار بتوحيده وإيمانه لأصابوا ولكن منزلة بين منزلتين وصاحبهما مخلد في النار مما لا يقتضيه عقل ولا سمع بل النصوص الصريحة المعلومة الصحة تشهد ببطلان قولهم والله أعلم وأيضا فصاحب الشائبتين يعلم حكمه من نصوص الوعد والوعيد فإن الله سبحانه وتعالى رتب على كل عمل جزاء في الخير والشر فإذا أتى العبد بهما كان فيه سبب الجزاءين والله لا يضيع مثقال ذرة فإن كان عمل الشر مما يوجب سقوط أثر الحسنة كالكفر كان التأثير وإن لم يسقطه كالمعصية ترتب في حقه الأثران ما لم يسقط أحدهما بسبب من الأسباب التي نذكرها إن شاء الله فيما بعبد والمقصود أن درجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة وخلافة الرسالة هي أفضل درجات الأمة ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم بتعليمهم وإرشادهم أو علم غيره شيئا من ذلك كان له مثل أجره ما دام ذلك جاريا في الأمة على آباد الدهور وقد صح عن النبي أنه قال لعلي بن أبي طالب والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم
وصح عنه أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا وصح عنه أيضا أنه قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وصح عنه أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وفي السنن عنه أنه قال إن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها وعنه أنه
قال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير وعنه أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ عظيم وافر وعنه العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد وعنه أنه قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداهما كما سمعها والأحاديث في هذا كثيرة وقد ذكرنا مائتي دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة وأوصالا متفرقة وصحف حسناته متزايدة يملي فيها الحسنات كل وقت وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب تلك والله المكارم والغنائم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعيه يحسد
الحاسدون وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها ويسبق السابقون إليها وتوفر عليها الأوقات وتتوجه نحوها الطلبات فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه وأصحاب هذه المرتبةيدعون عظماء في ملكوت السماء كما قال بعض السلف من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء وهؤلاء هم العدول حقا بتعديل رسول الله لهم إذ يقول فيما يروى عنه من وجوه شد بعضها بعضا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وما أحسن
ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ومن ضال جاهل قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وذكر ابن وضاح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب
الطبقة الخامسة أئمة العدل وولاته الذين تؤمن بهم السبل ويستقيم بهم العالم ويستنصر بهم الضعيف ويذل بهم الظالم ويأمن بهم الخائف وتقام بهم الحدود ويدفع بهم الفساد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقام بهم حكم الكتاب والسنة وتطفأ بهم نيران البدع والضلالة وهؤلاء الذين تنصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن عز و جل يوم القيامة فيكونون عليها والولاة الظلمة قد صهرهم حر الشمس وقد بلغ منهم العرق مبلغه وهم يحملون أثقال مظالمهم العظيمة على ظهورهم الضعيفة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيل أحدهم إما إلى الجنة وإما إلى النار فقال النبي المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن تبارز وتعالى وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا وعنه إن أحب الخلق إلى الله وأقربهم منه منزلة يوم القيامة إمام عادل وإن أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة إمام جائر أو كما قال وهم أحد السبعة الأصناف الذين
يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وكما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ظلا بظل جزاء وفاقا ولو لم يكن من فضلهم وشرفهم إلا أن أهل السموات والأرض والطير في الهواء يصلون عليهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم وولاة الظلم يلعنهم من بين السموات والأرض حتى الدواب والطير كما أن معلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائكته وكاتم العلم والهدى الذي أنزله اله وحامل أهله على كتمانه يلعنه الله وملائكته ويلعنه اللاعنون فيا لها من منقبة ومرتبة ما أجلها وأشرفها أن يكون الوالي والإمام على فراشه ويعمل بالخير وتكتب الحسنات في صحائفه فهي متزايدة ما دام يعمل بعدله ولساعة واحدة منه خير من عبادة أعوام من غيره فأين هذا من الغاش لرعيته الظالم لهم قد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ويكفي في فضله وشرفه أن يكف عن الله دعوة المظلوم كما في الآثار أيها الملك المسلط المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بعثتك لتكف عني دعوة المظلوم إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض فإني لا أحجبها ولو كانت من كافر فأين من هو نائم وأعين العباد ساهرة تدعو الله له وآخر أعينهم ساهرة تدعو عليه
الطبقةالسادسة المجاهدون في سبيل الله وهم جند الله اذين يقيم بهم دينه وييدفع بهم بأس أعدائه ويحفظ بهم بيضة الإسلام ويحمي لهم حوزة الدين وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله وتكون
كلمة الله هي العليا قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دينه وإعلاء كلمته ودفع أعدائه وهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها وإن باتوا في ديارهم ولهم مثل أجور من عبدالله بسبب جهادهم وفتوحهم فإنهم كانوا هم السبب فيه والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر والوزر ولهذا كان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال لكل منهما بتسببه مثل أجر من تبعه وقد تظاهرت آيات الكتاب وتواترت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح أهله والإخبار عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات ويكفي في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين ءامنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة الدال عليها رب العالمين العليم الحكيم فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فكأن النفوس ضنت بحياتها وبقائها فقال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يعني أن الجهاد لكم لكم من قعودكم للحياة والسلامة فكأنها قالت فما لنا في الجهاد من الحظ فقال يغفر لكم ذنوبكم مع المغفرة يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم فكأنها قالت هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا فقال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين فيا لله ما أحلى هذه الألفاظ وما
ألصقها بالقلوب وما أعظمها جذبا لها وتسييرا إلى ربها وما ألطف موقعها من قلب كل محب وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم ومن هذا قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن ءامن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه وضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يستوي عنده عمار المسجد الحرام وهم عماره بالاعتكاف والطواف والصلاة هذه هي عمارة مساجده المذكورة في القرآن وأهل سقاية الحاج لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيل الله وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده وأنهم هم الفائزون وأنهم أهل البشارة بالرحمة والرضوان والجنان فنفى التسوية بين المجاهدين وعمار المسجد الحرام مع انواع العبادة مع ثنائه على عماره بقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من ءامن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فهؤلاء هم عمال المساجد ومع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات ومغفرة
ورحمة وكان الله غفورا رحيما فنفى سبحانه وتعالى التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة ثم أخبر عن تفضيلهم عليهم درجات
وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس من جهة أن القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجات إن كانوا هم القاعدين الذي فضل عليهم أولو الضرر فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا وعلى هذا فما وجه استثناء أولي الضرر من القاعدين وهم لا يستوون والمجاهدين أصلا فيكون حكم المستثني والمستثنى منه واحدا فهذا وجه الإشكال ونحن نذكر ما يزيل الإشكال بحمد الله فاختلف القراء في إعراب غير فقرىء رفعا ونصبا وهما في السبعة وقرىء بالجر في غير السبعة وهي قراءة أبي حيوة فأما قراءة النصب فعلى الاستثناء لأن غيرا يعرب في الاستثناء إعراب الاسم الواقع بعد إلا وهو النصب هذا هو الصحبح وقالت طائفة إعرابها نصب على الحال أي لايستوي القاعدون غير مضرورين أي لا يستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون والاستثناء أصح فإن غير لا تكاد تقع حالا في كلامهم إلا مضافة إلى نكرة كقوله تعالى فمن اضطر غير باغ وقوله عز و جل في أول المائدة أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وقوله تعالى مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى فإن أضيفت إلى معرفة
كانت تابعة لما قبلها كقوله تعالى صراط الذين أنعمت عيهم غير المغضوب عليهم ولو قلت مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى لجرت غير هذا هو المعروف من كلامهم والكلام في عدم تعرف غير بالإضافة وحسن وقوعها إذ ذاك حالا له مقام آخر وأما الرفع فعلى النعت للقاعدين هذا هو الصحيح وقال أبو إسحاق وغيره هو خبر مبتدأ محذوف تقديره الذين هم غير أولي الضرر والذي حمله على هذا ظنه أن غيرا لا تقبل التعريف بالإضافة فلا تجري صفة للمعرفة وليس مع من ادعى ذلك حجة يعتمد عليها سوى أن غيرا توغلت في الإبهام فلا تتعرف بما يضاف إليه وجواب هذا أنها إذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيها إبهام لتعيينها ما تضاف إليه وأما قراءة الجر ففيها وجهان أيضا أحدهما وهو الصحيح أنه نعت للمؤمين والثاني وهو قول المبرد أنه بدل منه بناء على أنه نكرة فلا تنعت به المعرفة وعلى الأقوال كلها فهو مفهوم معنى الاستثناء وإن نفي التسوية غير مسلط على ما أضيفت إليه غيره وقوله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة هو مبين لمعنى نفي المساواة قالوا والمعنى فضل الله المجاهد على القاعد من اولي الضرر درجة واحدة لامتيازه عنه بالجهاد بنفسه وماله ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الفريقين كليهما موعود بالحسنى فقال وكلا وعد الله الحسنى أي المجاهد والقاعد المضرور لاشتراكهما في الإيمان قالوا وفي هذا دليل على تفضيل الغني المنفق على الفقير لأن الله أخبر أن المجاهد بماله ونفسه أفضل من القاعد وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس وأما
الفقير فنفى عنه الحرج بقوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فأين مقام من حكم له بالتفضيل إلى مقام من نفى عنه الحرج قالوا فهذا حكم القاعد من أولي الضرر والمجاهد وأما القاعد من غير أولي الضرر فقال تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وقوله درجات قيل هو نصب على البدل من قوله أجرا عظيما وقيل تأكيد له وإن كان بغير لفظه لأنه هو في المعنى قال قتادة كان يقال الإسلام درجة والهجرة في الإسلام درجة والجهاد في الهجرة درجة والقتل في الجهاد درجة وقال ابن زيد الدرجات التي فضل الله بها المجاهد على القاعد سبع وهي التي ذكرها الله تعالى إذ يقول تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم طمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين فهذه خمس ثم قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح فهاتان اثنتان وقيل الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين حضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة والصحيح إن الدرجات هي المذكورة في حديث ابي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي أنه قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي
ولد فيها قالوا يا رسول الله أفلا نخبر الناس بذلك قال إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة قالوا وجعل سبحانه وتعالى التفضيل الأول بدرجة فقط وجعله ههنا بدرجات ومغفرة ورحمة وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولي الضرر فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه
ولكن بقي أن يقال إذا كان المجاهدون من القاعدين مطلقا لزم أن لا يستوي مجاهد وقاعد مطلقا فلا يبقى في تقييد القاعدين بكونهم من غير أولي الضرر فائدة فإنه لا يستوي المجاهدون والقاعدون من أولي الضرر ايضا وأيضا فإن القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع التفضيل عليهم هم غير أولي الضرر لا القاعدون الذين هم أولو الضرر فإنهم لم يذكر حكمهم في الآية بل استثناهم وبين أن التفضيل على غيرهم فاللام في القاعدين للعهد والمعهود هم غير أولي الضرر لا المضرورون وأيضا فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر المجاهد كما ثبت عن النبي أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما وقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وعلى هذا فالصواب أن يقال الآية