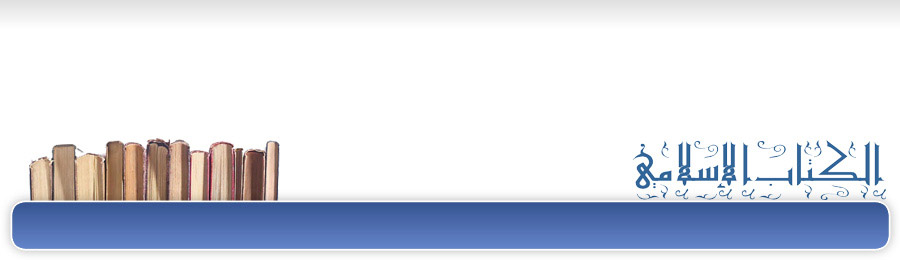كتاب:الخراج وصناعة الكتابة
المؤلف :قدامة بن جعفري
سائر الصناعات سوى الحياكة وعلى هذا قدر القمح من الزيت ومن غيره من سائر المطلوبات وقدر الزيت من غير القمح من جميع الصناعات فكان حفظ ذلك وتحصيله يصعب ويشق على من يبتنه وتفقده فضلاً عن الامي والمرأة والصبي وجميع من يبتاع ويبيع حاجة من أصناف الناس كافة فلما كان هذا على هذه الحال من المشقة لطف الناس بالتمييز الذي منحهم الله إياه إلى طالبوا شيئاً يجمع جميع الاشياء ويكون عند كل من يحتاج إليه من صناعة أو مهنة أو حبة أو ثمرة أو غير ذلك مما يدخل تحت الارادة ثمناً وقيمة واعتمدوا أن يكون هذا الشيء باقياً إذ كان هذا حكم ما يجعل ثمناً بجميع المطلوبات للحاجة إلى حفظه وادخاره وكان ما يسرع إليه الفساد والغير مما لا يصلح ذلك فيه فكان ما جعلوه ثمناً لكل مراد الذهب لطول بقائه على الزمان واحدة ثم لانطباعه على ما يطمح عليه وقبوله للعلامات التي تصونه والسمات التي تحفظه من الغش ثانية ثم كانت الفضة دون الذهب في النقاء فنزلوا لها مرتبة من القيمة حسب قدرها من بقاء الذهب وتطاول مدته ثم كان النحاس دون الفضة في البقاء فنزلوا له مرتبة في القيمة على حسب طبقته وكان اجود جميع المطلوبات في هذه الثلاثة الاصناف أولى في التدبير من الأمر الأول إذ كان يغرب وذاك لا يكاد يضبط ولا يتحصل ولهذه العلة احتيج إلى اتخاذ العين والورق وما يجري مجراهما واستعمال ذلك فيما تقدم شرحنا له الباب السابع في السبب الداعي إلى اقامة امام أو ملك للناس يجمعهم
لما دعت الحاجة إلى اجتماع الناس في المدائن والأمصار واجتمعوا فيها وتعاملوا وأخذ بعضهم من بعض وأعطوا وكانت مذاهبهم في التناصف والتظالم مختلفة وكان الله سبحانه قد شرع لهم شرائع وحد حدوداً مبينة احتيج إلى من يأخذ الناس باستعمال فروض الشرائع المسنونة ويقيم الحدود المبينة حتى يلزمها الناس كافة ولا يتعداها منهم أحد إلا أحلت به العقوبة التي تقوده إلى الشرع والسنة وتأتلف الكلمة وتلتئم البيضة وتجري أمور الكافة على التناصف والمعدلة ولا يقع في تعاملهم جور ولا مظلمة فإنه لا ملك إلا بدين وشرع ولا دين إلا بملك وضبط وقد وفق اردشير ابن بابك أن قال في ذلك قولاً ليس عنه معدل وهو أن الدين والملك اخوان توأمان لا قوام لاحدهما إلا بصاحبه وجعل الدين أساً والملك عماداً وقال في ذلك قولاً صواباً وقد كتب ارسطا طاليس إلى ذي القرنين في رسالته المنسوبة إلى سياسة الكل وتدبير الملك وأي ملك خدم دينه ملكه فالملك وبال عليه واي ملك جعل ملكه خادماً لدينه انتفع بملكه وبكل أمره في عاجلة وآجله وقد يقع في الظن جواز كون اكثر من ملك واحد لأمة واحدة أو عصابة غير مختلفة وفي ذلك غلط إذ ظن
لان فيه فساداً غير مخيل إذ كان الذي يحتاج إليه من الملك إنما هو القيام بالأمور على حقها والحق واحد لا يجوز أن يظن به غير هذا فليس يكاد يقوم بالحق الذي هو واحد إلا واحد وألا فلو ظن انه يقوم به اكثر من واحد لكان في الجائز أن يقع من الكثرة خلاف ولو من واحد وإذا خالف واحد فلا محالة انه يخالف الحق وإذا خالف الملك الحق فسدت الأمور فأذن لم يكن يجب أن يقوم بالأمور إلا واحد فأما من دون ذلك ممن يستعان بهم في الحفظ والحراسة والأعمال المهنية فيجوز أن تقوم به فليس يصلح أن يكون إلا واحد لا يشركه فيه غيره ولهذه العلة كان الإله واحداً لا شريك له وليس هذا موضع يحتاج ايضاح ذلك بالبراهين الدالة عليه فلا جرم أنا لم نأت فيه وقد أجمل الله سبحانه القول في ذلك بما شرحه واتضاحه عند الراسخين في علمه وهو قوله عز وجل ( ^ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) تبارك الله الاحد الله الصمد وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً الباب الثامن في أن النظر في علم السياسة واجب على الملوك والائمة
لما كان هذا النظر مما يلزم الملوك تعلمه ويليق بهم تقبله فقد يحق على افاضلهم دراسته ويجمل بهم وعيه وتحفظه لانهم إذا فعلوا ذلك حتى يحكموا أسبابه وعلله استقامت آراؤهم وإذا استقامت آراؤهم صلحت افعالهم وإذا صلحت أفعالهم عم نفع ذلك رعاياهم وجميع من يكون امورهم وان الصلاح والفساد اللذين يكونان في الأزمنة والاوقات إنما هما باستقامة افعال الملوك واعوجاجهم فإذا صلحت تدبيراتهم بصواب الرأي وسداد الفعل في وقت نسب ذلك الوقت إلى أنه وقت حميد وزمان شديد وإذا فسدت أحوالهم واضطربت مجاري امورهم في آخر نسب الوقت الذي يقع فيه هذا إلى انه وقت شديد بما يعرض لأهله من الفساد وسوء التدبير وأكثر الناس يظنون أن الملك يجري مجرى سائر الرياسات التي تستقيم لأكثر من منصب فيها لما شاهدوه وجرى في عاداتهم من أن كل من يوضع في رئاسة ما يقوم بها وترجوا أفعاله فيها وان كان غير مستحق لها ولا مضطلع بشأنها لان خلله أما أن يكون مضراً يشعر به أو يكون مما لا يتلافاه اعوانه وكفاته أو يكون آخر أمره معروفاً فيهون صرفه والاستبدال به غيره والملك فلا يحتمل خلة من الخلال التي ذكرناها لانه اشرف منازل البشر قدراً وأعظم الأمور خطراً فأن الملك المقيم لنظام الملك بالتحقيق لا بالذي
يأخذه بالهوينا وعلى جهة التشفيق يحتاج إلى أن يكون من المخاطرة بمهجته وتجشم الأمور التي يقيم بها اود مملكته ويصلح معها شأن من يتولى سياسته بمنزلة الحال في قلة مهواتها هلكة فأن لم يكن معه من شدة النفس وقوة الشكيمة ما يمضي به الأمور العظام التي يحتاج في الملك امضائها اضطربت الأحوال التي هو مضطر إلى تقويمها والتاثت الاسباب التي يقصد لنظمها وتعديلها فإن أيسر مخاوف الملوك انهم يحتاجون إلى أن تتمكن رهبتهم في نفوس الرعية ومن ينأ عنهم من الاعداء في المحال النائية ومع اشتداد الهيبة من الناس للشيء يقع لهم اضطرار بغضه ويتمكن في نفوسهم بغضه ومقته والشنأن له والابتهاج بمأساة وخالف محبته على أن هذا المقت للملوك لا يخلو من أن يخالطه الاستكانة ويشوبه الخضوع والمهانة ولا تكون المحبة للملك من رعيته نافعة إلا أن يكون معها هيبة فأن مما هو معلوم من الحكم القديمة انه إلا ينفع الإنسان محبته من فوقه إلا أن يكون معه رحمة ولا محبة النظير له إلا أن يكون معها شفقة ولا محبة من دونه إلا أن يكون معها هيبة ولما قدمناه من بغض العامة للملوك ما قال اردشير بن بابك في عهده أن من صيغ العامة بغض الملوك وفي هذا القول إذا أتى مطلقاً ما يعجب منه لان من يسمعه ولا يعرف سببه ينكره ويتعجب من كونه والسبب فيه أن في صيغ الناس محبة الفراغ والكراهة لمن يأخذ على أيديهم ينحوا بهم نحو الاستقامة ويمنعهم من الجري على ما تقوده إليه نفوسهم من اتباع الهوى والارادة ومن هذا بغض الصبيان للمؤدبين وكراهة الأحداث للمشايخ
وقد قال بعض الشعراء اليونانيين شعرا صورة الشعر لما ثقل من لسانهم إلى العربية وبقي معناه وهو الشيخ عند الأحداث رجل سوء
والملك الذي يقصد لاقامة الناس على العدل ويقودهم نحو الواجب مضطر إلى أن يكون كما قدمنا مهيبا مخوف الجانب يرهب الناس بأكثر مما يرغبهم ويشتد عليهم بأزيد مما يلين لهم ويكون معه من الغلظة اضعاف ما يكون معه من الرأفة لان الذي يجده مستحق السطوة بغية اكثر من مستوجب الرأفة بصالح سعيه إذا كان القليل من الناس ذوي هدى وحسن استقامة والكثير منهم أهل حسب وعرامة ويجتمع للملك بهيبته مع صلاح رعيته صلاح اعدائه ومن يقدر غلبته على مملكته ممن هو مقارب له أو نأى عنه فان في قول رسول الله دليلا بينا على ما قلته وذلك حيث قال نصرت بالهيبة دون غيرها فيما كان فيه من الاخلاق الرضية والحكم البليغة والشيم الشريفة وقد جاء في الأثر ما وزع الله بالسلطان اكثر مما وزع بالقران لان القران إنما هو حكم ومواعظ وترغيب في الجنة وتخويف من النار فلا جرم أن اكثر الناس لم ينقد لما وجب عليه من الوعظ والانذار دون ما انزل بهم من التأديب والايقاع وهذا كله اكبر دليل على أن الهيبة من اخص ادوات الملوك التي يكون معها من العامة البغضة ومما فيه دليل على ما قلته من ذلك أيضا قول شاعر العرب يذكر سادتهم وقياس السادة فيهم
عند جمهور الناس منهم قياس الملوك في غيرهم عند سائر عوامهم مصرع دماؤهم من الكلب الشفاء
قال احمد بن يحيى النحوي ذكر لي أن تفسير ذلك إنما هو لان دم السيد غاية الثأر وأنه إذا اصيب فقد أدرك الثأر كله ووقع الشفاء بعده قال وانما الكلب ها هنا الغيظ والغضب كما قال بعض الشعراء مصرع
( كلب بضرب جماجم ورقاب ** )
فالغيظ عندي من العرب على ساداتهم من جنس غيظ سائر الأمم على ملوكهم وإذ قلنا ما قلناه فليكن أول ما نتبع به ذلك ذكر أخلاق الملك وسجاياه وما يجب أن يكون عليه منها في ذات نفسه إذ كان ذلك مبدأ التدبير والسياسة ومنشأ الأفعال الشائعة في العامة ثم يتبع ذلك ما يجب أن يكون تابعا له الباب التاسع في أخلاق الملك وما يجب أن يكون عليه منها في ذات نفسه
ليس أحد اولى بسياسة نفسه ورياضتها على التهذيب والاستقامة والعقل والفضيلة والرأي والرجاحة من الملك لانه إذا فعل ذلك كان حقيقا في أول الأمر أن يرى نفسه فوق من هو سائس له مستوجبا للعلو على من هو دونه إذ كان ليس من الحق أن يكون الادنى فوق الاعلى ولا الاقصى متقدما للافضل ولا الجاهل مملكا على العاقل فأول ما ينبغي أن يكون من صيغة الملك العقل فانه افضل قوى النفس والعاقل اثير مكرم مرأس مقدم عند من به من الناس إليه حاجة وعند من لا حاجة به إليه والعقل منه مخلوق مع أول الفطرة ومنه مستفاد ومكتسب بعد ذلك باقتناء العلوم الحقيقية والتجربة البادرة عن الفهم والروية ومجاراة ذوي الاراء الوثيقة وأهل الاداب الصحيحة فإذا كان مع الملك العقل الأول امكنه أن يضيف إليه اكتساب الثاني وإذا اجتمعا قويا قوة لا يحتاج معها إلى وصية صار الملك بهم إلى السعادة التامة في الدنيا والآخرة وقد يعترض بينهما ويعوق عن اجتماعهما الهوى وغلبته وكثرة فنونه وتشعبه فليحذر الملوك من تسلطه فإنما هو كالنار التي تنمي من ضعف وقلة وتسعر من الشرارة الدنية حتى إذا اضطرمت وقويت لم يدرك اطفاؤها بالهوينا والحال السهلة فإذا دوركت قبل أن تقوى وبودر باضعاف الهوى قبل أن يتمكن ويشظى كانت القدرة عليه اسهل واستدفاعه قبل تمنكه أولى وأيسر وأمثل الطرق المأخوذ فيها بجسمه وأخلق السبل
التي تسلك في افنائه وتمحيقه هو أن يقصد الملك لعلم ما كان يجهله وتفهم ما كان غير فهم به فانه عند وصوله إلى ذلك يزول عنه ما كان متشعبا في نفسه من فنون الهوى ويضمحل ذلك أو جله ويتلاشى والهوى فمما لا ينبغي للملوك أن يحذروا شيئا اشد من حذرهم منه وألا يكونوا مجاهدين لعدو من أعدائهم قبل مجاهدتهم له فانه إذا عجز الملك عن مجاهدة هواه الخاص به كان اولى بالعجز عن غير ذلك مما هو خارج عنه فقد كان يقال من كان عقله لا يقوم بمصلحة خاصة لم يكن أهلا لان يستصلح به أمر عامته ثم العفة من رأى أن السخاء من الكرم بأن يقال أن الكرم إنما يستحق بالسخاء وذكر كما قدمنا انهما جنسان لا يعم أحدهما الآخر ولا يدخل تحته وذكر اختلاف أهل المشرق والشمال في المواهب وأنها انفس ما جرى في باب الكيفية أو ما كان داخلا في معنى الكمية وفضل مواهب الكيفية على مواهب الكمية لدخول الحكمة وسائر الصناعات في باب الكيفية وقال بعد ذلك لما صحح أن السخاء والكرم ممدوحان انهما بالملوك ازين وباخلاقهم ابهى واحسن وحكي قول شاعرهم المعروف بهوميروس حيث قال
لا ينال المراتب بخيل ولا يرتقي الدرجات العليا إلا كريم وقد قال قائلون أن من السخاء الإمساك عما في أيدي الناس مما لا حق يوجب أخذه منهم وليس هذا من السخاء ولا من الكرم بل هو في طريق المرؤة اذهب وامضاها الزم ومما ينبغي أن يكون الملك مجبولا عليه ومكتسبا لتقويته في نفسه عظم الهمة إذا كان ليس من شأن الملك إلا أن تكون كل افعاله الانسانية مبالغا فيها ينحو نحو الغاية القصوى على حسب قدره من المنزلة وعلوها ومحلة من ارتفاع الدرجة
وسموها ويحتاج الملك أن يكون شجاعا والشجاعة ضربان أحدهما الصبر على النوازل الملمة والخطوب النائبة والآخر الجرأة على الملاقاة والمنازلة على الحرب والمباطشة فان اجتمع الصنفان للملك فهو الكامل وألا اجزاه أن يكون الضرب الأول منهما
ومما يحتاج الملك إليه أن يكون بعيد الفكر متطلعا نحو العواقب ذا عزيمة في نفسه وشكيمة في رأيه حتى إذا صح عنده ما يوافق الصواب وان كان فيه بعض المخاطر امضى تدبيره فيه ولم ينكل عنه ولا يداخله فشل فيه ولا خوف منه والحلم فلا يصلح أن يكون الملك غير لابس له لأنه في أول الأمر بها يكسبه زينة ويكسوه وقارا وبهجة ثم يتلوا ذلك أن يصل إلى رعيته ومن يسوسه من الناس نفعة لان ذلك إذا كان معه سهل السبيل إلى التثبت في مواضع العقوبات على الاجرام التي يتكون بعضها واقعا على شبهة وبعض جاريا بسبب أقوال كاذبة وبعض على سبيل حيلة وعلى وجه معاداة غيلة فإذا كان مع الملك حلم ووقار وترفق وثبات لم تقع عقوبته إلا في حقها ولا مجازاته إلا في موضعها ولم يكن منه ما يوجب الذم ولا وقع من جهته ما يذكر معه ندم ومما لا يصلح مفارقة الملك إياه ولا خلوه منه الصدق في وعده ووعيده فانه إذا كان حليما متثبتا لم يعد إلا ما يتيقن قدرته على الوفاء به ولم يتوعد إلا من يستحق أن يتوعده بمثل ما يوجبه جرمه ولم يتهدد أيضا إلا بما له أن يفعله فإذا وعد في حقه ووأعد في كهنه لزمه أن ينجز ما وعده ولا يخلف ما توعد به
ومن كمال الخلال التي قدمنا حاجة الملك إليها أن يكون عادلا في نفسه مكتسبا لما حفظ هذه الفضيلة وزاد عليها بجودة البحث وعم الصواب كل أحواله واستقامت الخلال المحمودة التي تكون معه
وصواب النظر فان الملك إذا كان عادلا شمل الاقساط جميع افعاله وعم الصواب كل أحواله واستقامت الخلال المحمودة التي تكون معه حتى لا يجري شيء منها على سرف ولا تكثير ولا نقص ولا تقصير والشح من الخلال المذمومة التي لعلها تعرض له حتى يخلو منها أو من اكثرها بمعاتبته نفسه عليها ونهيه لها عنها وقد يستغنى الملك إذا كان عادلا من أن يكون رحيما لان الرحمة إنما هي تركيب في خلق النفس من ود وجزع فإذا عدل الملك حتى لا يضع عقوبته إلا في حقها كانت الرحمة ناقصة منها وعاد ذلك بالضرر في التدبير ومما يحتاج الملك أن يكون متطلبا له وناظرا فيه سير من تقدمه من الملوك ليقبل افعال من حمدت افعاله وكانت متصفة بالسداد أحواله ويتجنب سيرة من ذمت سيرته ولم يكن ممن ترتضى طريقته ويحتاج الملك أن يخلوا من خلال في كونها معه ضرر عليه في ذات نفسه وفي تدبير رعيته ومصالح مملكته منها اللجاج والمحك فإنهما لا يكونان إلا في الطباع الرديئة ومن الخلائق الدنيئة وهما مع هذا يعوقان مجاري الرأي عن الانبعاث ومنها البذخ فإنه تابع أبداً لصغر الهمة ومنها التهاون بالأمور فإن اليسير في ذلك ينتج كثيراً من الخطأ وعظيماً من البلاء
وقد ذكر مروان بن محمد وكان من أكابر ملك بني أمية وشجعانهم وذوي الرأي والسياسة منهم لما دفع إلى ملك قد وهت قواه وانتفضت عداه بإهمال المضيعين وتقصير المترفين فأخذ يروم تلافيه وقد عسر وتقصد لرتقه وقد زاد الخرق واتسع وباشر من حرب المسودة ما اشتد عليه حتى انهزم فلجأ في انهزامه
إلى موضع حصل فيه ومعه خادم رومي يقال له بسيل وكان هذا الغلام فيما يقال من أشراف الروم فوقع عليه سبى صار به إلى مملكته مروان فقال مروان في تلك الحال يا لهفاه على كف ما ظفرت ودولة ما نصرت ونعمة ما شكرت فأجابه بسيل بأن قال من أغفل الصغير حتى يكبر واليسير حتى يكثر والخفي حتى يظهر لقي مثل هذه الحال التي نحن عليها واغلظ وقال بعض حكماء الفرس ما أورث راحة ما أعقب نصباً ومعونة
وقال آخر منهم ما أهون الكد المؤدي إلى الدعة وأصعب الدعة المعقبة تعباً ومشقة وقال بعض البلغاء في ذلك ينبغي أن يستعمل الملك الحزم محتملاً مؤونته بصلاح بغيته وبجانب العجز تاركاً عاجل راحته لمكروه عاقبته فإن للحزم مؤونة تودي أهلها إلى الخفض والدعة وللعجز يسيراً من الراحة يفضي بمستعمله إلى الذل والضعة والكبر فينبغي للملوك الرجح أن يعدلوا عنه وينتفوا منه فإنه يكفي إذا كانت معه الخلائق التي قدمناها أن يعظم بها خطره ويجزيه أن يكرم من أجلها فإن الكبر يكسب صغراً ومقتاً والتواضع يجلب لمستعمله كبراً ووداً وقد قالت حكماء الفرس التواضع مع السخف والبخل احمد من الوقار والسخاء مع الكبر فأجمل بحسنة عفت من صاحبها على سيئتين وأقبح بسيئة محت من مستعملها جمال حسنتين
وقالوا أن أصل التكبر اعجاب المرء بنفسه ووضعه أياها الموضع الذي يتزيد فيه على حقه وذكروا أن ذلك غاية التكدر والبلوغ فيه نهاية حال المتزيد لأن من ترسم بالكذب وندم عليه إنما يكذب بأن يقول ما لا وجود له ويزيد على منزلة الكاذب بالقول من يكذب في فعله وهو المرائي لأنه يظهر بالفعل ما لا يعتقه ومنزلته عندهم في الكذب أغلظ من منزلة الذي يكذب فجد قوله لأن هذا
يجمع إلى كذب القول كذب الفعال والاول إنما كذبه في اللسان والمنزلة المتناهية في الكذب هي منزلة من يكذب باعتقاده لانه يعتقد في نفسه ما لا يجده منه غيره فيكون المعجب قد جمع الكذب باللسان والفعال والاعتقاد فإن كان الكذاب مذموماً فالمرائي أذم منه وان كان المرائي أشد في باب الذم من الكذب فالمعجب أولى من المرائي الذي يتقدم في الكذب طبقته وإذا كان الملك أولى الناس بالبعد عن الكذب باللسان وأزيد من ذلك أن يبعد عن الكذب بالفعال وأزيد منهما أن يكون كاذباً بالاعتقاد الذي ينضاف إليه الكذب باللسان والفعال وواجب عليه أن ينفي العجب بالتواضع ويغني عن الكبر بلين الجانب لأنه لا شيء أجل من أن تقابل النعمة كلما عظمت بالشكر ويجازي المنة كلما جلت بالحمد كما كان من أخلاق رسول الله ولا خلق أولي بأن يتقبل من خلقه وليس لأحد عظم شأنه ولا للملك وإن عز سلطانه أن يظن بنفسه ارتفاعاً عن حاله وقد كان التواضع سجيته وترك الكبر خليقته
ومما يحق على الملك أن يفعله ولا يخلو منه مجالسة الحكماء ومعاشرة ذوي الرأي والحجي فإن انطياعه لهم وتقبله مذاهبهم واخلاقهم يبعده عن أمر العامة الذي هو في غاية المضرة ولا سيما على الملوك وذوي الاقدار العالية وفي ذلك وحده لو لم يتعلق بغيره مجزي وكفاية فكيف به إذا شذا الشيء بعد الشيء منهم وتعلق بحكمهم وعلومهم وفيما أثبت من توقيع انوشروان انه رفع إليه يسأل عن السبب في مجالسة أهل العلم والرؤساء من أهل كل صناعة فوقع أن انتشار ذلك عنا تقوية لملكنا واضافة لعددنا والوجه أن يعلم أن هذا الرأي الذي وقع لانوشروان
مما لم تزل الحكماء تأمر به والملوك الحزم تتحاض عليه وتجتهد في أن تنشر عنها فعله واستعماله وممن كان على هذه الحال في اختياره العلماء ومعاشرته اياهم وقبوله مشوراتهم الاسكندر ذو القرنين
ولا جرم انه ما يذكر أن ملكاً استولى على ملك الشرق والغرب وما بينها ودانت له الأمم كلها غيره وان معلمه كان ارسطا طاليس وعنه أخذ الحكمة وكان أول أمر الاسكندر أن أباه فيليب كان ملكاً من ملوك اليونانيين وكان حكيماً ففكر بعد مضي أكثر عمره في أمور الناس المضطربة ومذاهبهم المختلفة الفاسدة فتشكي إلى جلسائه من الحكماء اغتمامه بذلك وتوقه إلى الصلاح العام وعزمه على قصد الملوك الضلال ليبصرهم الحق ويجاهدهم عليه فرأى من يليه من الحكماء ويحف به من صالحي الجلساء صواب هذا الرأي وخاطبوه بأنه أن ما بعثه عليه ودعاه إليه همة عالية ونفس سامية وان سنة قد تعالت ولا يؤمن أن ينهض نحو هذه الحال وهي مما يحتاج فيه إلى مباشرة أمور عظيمة وتجشم اسفار شاقة وملاقاة حروب صعبة ومدة يرجى في مثلها تمام هذا الأمر من الصلاح وتطاوله وانهم لا يأمنون أن تخترمه قبل ذلك المنية وأشاروا عليه بالاستكثار من النساء للطروقة وكان متجنباً لذلك فيما خلا من عمره على مذهب الفلاسفة طلباً لولد ينشئوا نشوءاً صالحاً ويعهد إليه في طلب ما رام فعله فولد له الاسكندر فلما ترعرع أنفذه إلى اثينا مدينة الحكماء وكان صاحب التعليم بها في ذلك الوقت ارسطا طاليس بعد أفلاطون فأقام عنده حتى شد من الفلسلفة طرفاً وتقبل أخلاف أهلها ثم
أتاه نعي أبيه وجاء أهل مملكته بعد موته إلى الاسكندر ومعهم التاج وما يتبعه من ادوات الملك وكانت له أقاصيص مع معلمه ليس يدخل أكثر فيما يحتاج في هذا الموضع إلى ذكره وإنما وصفت ما وصفته من حاله المتقدمة ليعلم أن الملك انه إذا تشاغل بالحكمة كان أمره عظيماً وشأنه جسيماً كما كان ذو القرنين وقد جاء في الأخبار القديمة أن الله عز وجل إذا أراد بامة خيراً جعل الملك في علمائهم والعلم في ملوكهم وقد قال عز من قائل في كتابه المحكم ( ^ إنما يخشى الله من عباده العلماء ) وتفسير الخشية في هذا الموضع التقى وكف اليد عن جميع المساوئ وليس أحد يظن انه اعلم بما يرضى الله ويسخطه من العالم الذي يعلم أمر الله على كهنه واقصى ما جعل الله للبشر علمه من ملكوته وسلطانه على أن العالم بذلك قليل والفاحص عنه والمتبحر له يسير لا جرم أن التقى قليل والجهل كثير والله عز وجل قبل ذلك وبعده ولي الارشاد والتوفيق
ومما ينبغي أن تعرفه الملوك أن امورهم ليست كأمور سائر الناس الذين يجوز لهم التساهل في شؤونهم لأن كل إنسان من السوقة المنفردين بما يخصهم يكفيه من الفضائل وتضره من الرذائل دون ما يكفي ويضر من يضم الجماعة الكثيرين الذين تصرفهم به ورجوعهم إلى الاتمار له فإن الواحد من السوق مثلاً يكفيه في أن يكون فهماً أن يفهم أمره وأمر ما يخصه ويجزيه من العلم يسير ما يسد به ويقتنيه وكذلك يجزيه أن يكون شجاعاً أن يفي بقرنه وفي أن يكون أميناً يؤدي ما يؤتمن عليه نفسه وفي أن يكون عادلاً أن يعدل فيما يأخذه ويعطيه وحده وفي أن يكون
جائزاً مع هذا يسئل عما لا يخبره كل الخبر ولم يقع له تصحيحه بغاية الصحة ولا متمكن منه فكم من نافذ في شيء يضعف من غيره وما هو بشيء لم يقع له التمهر بسواه حتى أن لم يسلم علمه بغيره وتكلف منه مالاً يتحقق معرفته لأن في طبائع الناس المشاحة في فطرهم والمساماة والمغالبة حتى إذا سلم المستشار من كل ما عددته وكان مستقيم الرأي غير خطلة وسديد التدبير غير مختلة لم يأمن أن تعرض له آفة أخرى في أن يكون له أرب فيما ليس الصواب للملك قبوله منه أما من التعصب لمن يودي عن صدق النصيحة في أمره أو المعاداة لمن يحض على مكروهه ويبعث على مساءه وضره وإذا خلا من جميع ما عددته جاز بعد هذا أن يكون له خليفة في نفسه لا تليق بمن يكون على مثلها الرجوع في الرأي الذي يشاور فيه إلى ما عنده مثل أن يكون قصير الهمة ثم ليستشار في الأمور السامية أو يكون جباناً فيشار في الاقدام على الأحوال الخطيرة الهائلة أو يكون بخيلاً ضنيناً ويشاور في صلات من يستحق التوسعة في صلته وما جانس هذا وشاكله من الخلائق التي تكون في الناس ولا يمكن ضبطها ويعجز العالم عن مقاومتها ومقاومة ما فيه منها فكم من عالم عاقل يعلم أن فيه من الخلائق المذمومة ما هو مبلحاً به ويجتهد في الزوال عنه فلا تبلغه قدرته ويعجز عنه محالته فإذا كانت هذه الافات لاحقة للمشاورين فكيف بتصحيح مشوراتهم وكيف يستخلص حقيقة الصواب من جهتهم إلا بأن يكون للملك في النهاية من الفهم والدراية حتى يعلم صحة فهم من يشاوره فيما يشاوره فيه وتصرف خلائقه في الوجوه الخاصة به وسلامته من أن يدخله في ذلك هوى أو يكون له في شيء انحراف أو عداوة
جواداً أن يجود على من تبلغ قدرة الجود على مثله وكذلك الرذائل يجزيه إذا بلى بواحدة منها إلا يعدوه عيب مما بلى به ولا يتخطاه أي غيره
وليس الملك كذلك لأنه لا يكفيه من العلم أن يكون معه منه ما يقوم بأمره حتى يقوم بأمر غيره ممن إليه تدبير شأنه وكذلك فلا يجزيه في الأمانة أن يؤديها هو وحده حتى يؤديها اصحابه والمؤتمنون من قبله ويكونوا من الأمانة على مثل ما هو عليه وكذلك في الشجاعة ولا يجزيه أن يقاوم قرنه حتى يدبر جيوشه تدبيراً يقوم معه كل واحد منهم أيضا بقرنه ويحمل كل واحد منهم نفسه وكذلك في العدل يحتاج أن يفيضه هو ويفيض مثله اصحابه وكفاته وكذلك جوده يحتاج أن يكون أهم من جود غيره وأشد احتياطاً في أن يوضع مواضعه وعند مستحقه ولا يخلوا مستوجب له مما شكل نظيره منه وكذلك أيضا فليست عيوبه وما يبدو منه من قبيح اموره يخصه دون أن يفسد احوالاً كثيرة من الأمور التي يتصل به مما لا يشاكله فساد السوق ولا يقاربه فلذلك لا يجب أن يكون موارد رأيه ومصادرها خارجة إلا بعد أحكامها وتهذيبها من شوائب الزيغ والفساد ودواعي الهوى المبعد عن الصواب وهذه الحال فما أبعد تمامها للإنسان وحده دون المشاورة والرجوع إلى ذوي الرأي والحنكة ومن قد هذبت العلوم الصحيحة رأيه وثقفت المعارف الحقيقية لبه ومن قد جرب التجربة المستوفاة لمثل ما يرجع فيه إلى رأيه ومعرفته وفي رجوع الملك إلى غيره من المشورات نفع ودفع للآفات وعوارض الخطأ والنكبات لأن المستشار ينبغي أن يكون أولاً صحيح العلم في ذاته مهذب الرأي في نفسه فما أكثر من العلماء من تكون آراؤهم معوجة ومقاصدهم مقاصد غير مستقيمة فإذا سلم المستشار من هذه الخلة كان
وقد أوصى مهبوذ أحد حكماء الفرس بعض ملوكهم فقال اتخذ من نصحاء علمائك مرآة لطباعك ليجود بها رأيك فأنك إلى صلاح طباعك أحوج منك إلى تحسين صورة وجهك والعالم الناصع في تعريف المخبر أصدق من الجديد المجلو في تبين النظر وقد قال شاعر من شعراء العرب
( وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه ** وما كل مؤت نصحه بلبيب )
( ولكن إذا ما استجمعا عند واحد ** فحق له من طاعة بنصيب )
فإذا عرف الملك سلامة من يشاوره من هذه الشوائب التي وصفنا وشاوره فيما يحتاج إليه طالبه بالدليل على أن يكون الذي يرتئيه وينص عليه هو الصواب دون غيره فإذا أتى بالحجة في أنه أصوب الوجوه التي يوجها الرأي ميز الملك ذلك بعقله ووزنه بمعيار نظره واعتباره فأن الملك عند فعله ما قدمته إذا أتمن انساناً كان أميناً وإذا استنجد رجلاً كان نجداً وإذا استكتب كاتباً واتخذ صنيعاً من سائر صنوف أصحاب الصناعات والمهن كان في معناه بليغاً سديداً وتحصل له جمهور ما يعلمه على حقه وصدقه وصوابه وتظهر افعاله متعجباً منها مفضلاً بها بينا فيها
الجزالة وصواب الرأي ما يكسبه شدة الطاعة من الخاصة ومن العدل والرأفة وما يصيره إلى الود الخالص من العامة ويتم له مع ذلك الملك الصحيح الذي هو الملك بالحقيقة لا الذي يجري على سبيل القهر والغلبة فإن مثل هذا ليس ملكاً على الصحة ولا رئاسة يوثق بها الثقة التامة إذا كانت الرئاسة إنما هي رئاسة عفو الطاعة لا رئاسة الاستكراه والقهر والمملكة مملكة الرضا والمحبة ولا مملكة التسلط والقهر
ومما ينبغي أن تذكره من أمر خلائق الاسكندر ذي القرنين ليتقبل الملوك ذلك ويذهبوا بنفوسهم نحوه ولا ييأسوا من بلوغ مثل حاله فأن الناس واحد في المعنى وأفضلهم عند الله التقي الذي يجده عز وجل عندما يحب ويرضى فأنه يبلغ الغاية القصوى ويسمو إلى الدرجة العليا ولو كان من الملوك ما بلغه موضعاً من احاديثه ما تسمعه الملوك ولا ينكلوا عن تعاطي مثل أمره والله ولي التوفيق بقدرته فما كان من أمر الاسكندر بعد ما اقتصصناه من ذكر أوليته وابتداء نشوئه وتعليمه انه كان مع حاله التي وصفناها عنه موذناً بالنجابة منذ أولية كونه وابتداء صباه ونشوئه ومن ذلك أنه كان لما اشخصه أبوه إلى مدينة الحكمة كان وجماعة من اولاد الملوك بحضرة المعلم المتقدم ذكره فأراد معلمهم امتحانهم والمقايسة بينهم فقال لفتى منهم يقال له مينوان افضى اليك الملك ما أنت صانع بي فقال أفوض اليك جميع امري وقال لآخر منهم يسمى فاليغا مثل ذلك فقال اتخذك وزيراً ومشيراً وقال لآخر يعرف بارقيطن فأنت ما تصنع بي قال أشركك في ملكي فقال للأسكندر مثل ما قاله لكل واحد منهم فقال يا أيها الحكيم لا ترتهنني اليوم لغد ولا تسألني الآن عما أفعله بعد وانظر
فإني أن أصير إلى الحال التي أومأت إليها أفعل بك ما ينبغي أن يفعل بمثلك في تلك الحال فقال معلمه حقا أنك لتخيل بملك كبير وعلى ذلك تدل قريحتك والفراسة فيك
ثم لنرجع إلى حديثه الأول الذي كنا بدأنا به فلما رجع الاسكندر بعد موت أبيه ورجوع الملك إليه إلى دار مملكتهم وكانت في ذلك الوقت بمقدونية وهي بالقرب من المغرب ولم يكن بالقسطنطينية التي هي في هذا الوقت دار ملكهم وبدأ في أول أمره بإصلاح مملكته حتى أقامها على ما وجب إقامتها عليه من السنن العادلة والسير الفاضلة ثم عزم بعد ذلك على تدويخ الأرض ومجاهدة الملوك الضالين وكانت للفرس على اليونانيين إلى ذلك الوقت أتاوة ولم تزل يحملها ملوكهم في كل سنة فأخذ في منع دارا بن دارا ملك فارس كان على عهده منها وأقبل دارا يكاتبه بالوعيد الشديد ويتهدد معلمه التهدد الغليظ وينسب المشورة عليه بترك حمل الأتاوة إليه والاسكندر يجيبه عن كتبه بأنه لو علم حقا يوجب حمل الأتاوة لحملها ولم يمتنع منها ويدعوه إلى التوحيد وترك الكفر ويحضه على اتباع أمر الله والتسليم له واعتماد طاعته والتناهي عن مخالفته ويحذره عقوبته وسخطه إلى أن أحس دارا ذلك فدلف إليه وقصد حربه ومناجزته وصار إلى ديار ربيعة ما بين المدينة المسماة باسمه وأقبل الاسكندر نحوه مظهرا مجاهدته مخاطبا له بأنه ما يريد ماله ولا شيئا مما يملكه وأنه إنما يريد منه أن يقر بالتوحيد ويؤمن به ويدع الكفر وينزع عنه لينصرف عن حربه ويخلي بينه وبين مملكته وأقبل دارا في جواب هذه المكاتبات يتعالى تعالي الجبارين ويتسطى تسطي الملوك المتعظمين إلى أن كان الظفر للاسكندر به فاستباح عسكره وتزوج روشك ابنته وأقبل إلى بلد بابل حتى دخله ووطئه واجتمعت ملوك الفرس من الآفاق إليه فأحسن عشرتهم واستعمل العدل في أمورهم ولم يهجم بسوء في شيء
من أحوالهم وكان عند انجذابه لملاقاة دارا قد استخلف معلمه أرسطا طاليس على ما خلفه وكان يطالعه بأحواله ويستمد الرأي من جهته فكتب إليه عند حلوله بأرض فارس واجتماع من اجتمع من ملوكهم قبله كتابا يقول فيه
أما بعد فان الأقدار وسابق الاتفاقات وان كانت أصارت بنا إلى ما نحن عليه من علو الشأن فليس ذلك بمانع لنا من الرجوع إلى رأيك والاستضاءة بنور حكمتك وأني لما حللت ببلاد فارس اجتمع إلي ملوكهم من الأقطار فرأيت أجساما عظيمة ونفوسا عالية وهمما سامية وشجاعة كاملة وأحوالا ضخمة واسعة ووجدت مقامي وسط بلادهم وقد استوليت على مملكتهم وظفرت بملكهم غرارا إذا كنت لا أمن أقدامهم وفكرت في قتلهم فأحجمت عنه لأني لم أعرف وجهه وقد صرت في أمورهم على حال محيرة فأشر بما تراه صوابا في تدبيرهم
فأجابه أرسطاطاليس وهو معلمه الذي أنشأه وبصره جوابا ينبغي أن يتمثل في جوابات الملوك ويتقبل في مخاطباتهم فإن الملك لو جاز أن يتعالى عليه أحد لوجب لذلك الحكيم الذي كان سبب تثقيفه ولكن من شأن الملك أن يتواضع له كل ذي عمل ويتطأطأ دونه كل ذي فضل فإن في جواب هذا الحكيم لهذا الملك العظيم تبصرا في مخاطبة الملوك واحدة مع ما فيه من الإرشاد إلى تعلم صواب الرأي ثانية وهو هذا وصل إلي كتاب الملك وفهمته فأما قوله أن الأقدار والاتفاقات ساقت إليه الأحوال التي هو بها فليت الأقدار إذا ساقت إلى أحد حالا عظيما كان مستحقا لها كاستحقاق الملك المنزلة التي وصل إليها فإن الفراسة فيه قد كانت توجيها وأقوال الكهنة تؤذن بها وتدل عليها
وأما قوله في رجوعه في الرأي إلي فالأحوال الكبار تشغل الملك عن الانفراد بالرأي وتقطعه عنه وليس رجوعه فيه إلي لنكوله عن عمله ولا قصور من رأيه عن بلوغه ولكن لأذكره بما أفدته منه وأرد عليه ما اسلفنيه من قريحته والله يوفق من ذلك ما يرضي الملك ويزلف عنده
فأما ما شاهده الملك من بأس الفرس ونجدتهم فينبغي أن يعلم الملك أن الأمم اقتسمت الفضائل فالذي وقع للفرس منها هو الشجاعة والنجدة فأما قتلهم فلست أراه لأنه إن قتل ملوكهم وليس بد من أن يستعمل عليهم بعضهم اضطر إلى رفع سفلتهم وسياسة الملوك أسهل من سياسة السفلة لأن الملوك أشد طاعة وأسلس انقيادا وعريكة وسياسة السفلة شاقة متعبة وأنا أرى رأيا يكتفي به الملك مؤونة قتلهم مع ما يجتمع له به من طاعتهم ويستثمره من إخلاص نياتهم والانتفاع بهم وهو أن يجمعهم في محفل عظيم عام ويعمد إلى أولاد الملوك الذين لا يأبى أحد من كافتهم رياستهم فيقسم المملكة بينهم ويجعلها طوائف في أيديهم فإنه إذا رأى كل امرى منهم أنه قد ساوى نظيره في التمليك لم تطعه نفسه للانقياد له وان يكون دونه ولقلة مقدار الطائفة التي في يده من المملكة عند جميعها ما ينقص همته عن معصية الملك والخلاف عليه ويستجمع الملك طاعتهم ويكفي ما ترهبه من غدرهم وشرتهم فرأى الاسكندر صواب هذا الرأي فقبله فلم يزل ملوك الطوائف يؤدون الأتاوة إلى اليونانيين وينحون لهم بالطاعة خمسمائة وإحدى عشرة سنة إلى أن جمعهم أردشير بن بابك وقال لما تكلف من جهادهم على الجمع
المشقة الشديدة والكلفة المتعبة حتى صارت المملكة واحدة نحن نضرب بسيف أرسطا طاليس مذ هذه المدة البعيدة
وكتب أرسطا طاليس إلى الاسكندر رسائل كثيرة في حال محاربته دارا إلى أن ظفر به وبعد ذلك في حال مسيره إلى الهند ومحاربته فور ملكهم إلى أن ظفر أيضا به ثم في نفوذه إلى الصين وأقصى المشرق بين له وجوه الرأي والتدبير ويحضه على الحكمة والعلوم النظرية ويبصره الأخلاق الشريفة والأفعال الجليلة منها رسالته المعروفة برسالة التدبير فإنه يقول الحكمة رأس التدبير وهي صلاح النفس ومرآت العقل وبها تزول المكروهات وتعز المحبوبات ما أحسن رأي من حقق في طلبها وأبهى نتائج الحكمة في نفوس طالبيها وهي أس الممادح وأصل المفاخر وكفى بالحكمة فضلا أن في حجة من رام أبطالها تثبيتها ومن قصد لدفعها بحقيقها وكفاها بأنها معشوقة في الطبيعة ومتشوق إليها في أول الصيغة وان الدليل على ذلك ما قلناه في كتاب يسمع الكيان من أن الصبيان يشتاقون إلى سماع أحاديث الخرافات وان جميع الحواس سريعة إلى استنباط محسوساتها وكفاها فضلا أن الجهل ضدها وهو الشيء الذي ينتفي منه الناس جميعا ويتدافعونه طرا وبها ينال الدنيا حق المنالة وهي العائدة إلى الفوز في العاقبة وبها تنجوا النفس من العقوبة وخاطبه فيها مخاطبات أخرى نحن نضع كل باب منها في موضعه
ومما يصلح أن يكون في هذا الموضع أن قال له اعلم يا اسكندر أن الرئاسة مرغوب فيها ليحرز الذكر بها والذكر محمود لمن مال إليه من طريقه ومذموم لمن يقصده بالإفراط فيه فطلب الذكر من وجهه ينتج الصدق والصدق ينتج الورع وجميع الممادح والورع ينتج
العدل والعدل ينتج التآلف والتآلف ينتج الكرم والكرم ينتج المؤانسة والمؤانسة تنتج الصداقة والصداقة تنتج البذل والبذل والمؤساة توجب الذب والمحاماة وفي ذلك اقامة السنة وعمارة الدنيا وهو موافق للطبيعة وكفى بالطبيعة التي هي قوة الباري ففي جميع الموجودات في اصلاح جميع الأمور الفاسدة المضطربة وطلب الذكر من غير جهته ينتج الحسد والحسد ينتج الكذب والكذب اصل المذام كلها وان الكذب ينتج النميمة والنميمة تنتج البغضاء والبغضاء تنتج الجور والجور ينتج التصادم والتصادم ينتج الحقد والحقد ينتج المنازعة والمنازعة تنتج العداوة والعداوة تنتج المحاربة والمحاربة تنقض السنة وتذهب بالعمارة وهذا مخالفة الطبيعة ومخالفة الطبيعة فساد الأمر كله وقد ينازع النفس أيضاً منازع غليظ المؤونة وهو الشهوة المفرطة وينتج افراط الشهوة الميل إلى البدن وتضييع اصلاح خواص النفس وقواها فإن الميل إلى الجسد ينتج الاهتمام المفرط وافراط الاهتمام ينتج البخل والبخل ينتج محبة اليسار وحب اليسار يدعوا إلى النذالة والنذالة تنتج الطمع والطمع ينتج الخيانة والخيانة اصل السرقة والسرقة تهتك المروة ومنها تنشي المحاربة التي ألف بعدها بالحقيقة والمحاربة اصل لنقض الدين وزوال التآلف وخراب الدنيا وفناء عمارتها وذلك مخالف لارادة الباري ومشيئته وقد ينازع النفس أيضا منازع ليست مؤونته بالسهلة وهو النهم لأن النهم ينتج الدنأة والدنأة تنتج سقوط الهمة وسقوط الهمة تنتج الميل إلى المحقرات وذلك هتك كل فضلة ومن هذه الافة تحدث الأوجاع العظيمة والآلام المؤذية والاسقام المزمنة والفجور وما
أشبهه من الأمور القبيحة وكذلك القحة فإنها من خواص الدوائر الغالب عليها سوء المزاج وهي معدن الاوساخ التي تحارب الفكر واصل لأكثر الرذائل
وقال بعد ذلك انه قد يجب على الملك أن يختص بأحسن الخواص وذلك انه علم يشار إليه وامام يؤتم به وصغير العيب في الملك عظيم وكذلك الفضل منه ضوء كثير
وكان معاوية ابن أبي سفيان يقول أن الأمور لترد علي فيطول بها نظري حتى أخاف أن احبس عقلي فاستجم عقلي بمحادثة العقلاء تم اعاود النظر فيها وقد انقشعت عنه صبابة الحيرة فاصدرها مصادرها
وأخبرني سنان بن ثابت بن قرة أن المعتضد بالله وكفى به من الملوك فضلاً وحزماً أنه لما أراد بناء قصره في أعلى بغداد على الموضع المعروف بالشماسية استزاد في الذرع بعد أن فرغ لها من تقدير جميع ما أراده للقصر فسئل عما يريد ذلك له فذكر انه يريده ليبني فيه دوراً ومساكن ومقاصير يرتب في كل موضع منها رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم النظرية والعملية ويجري عليهم الأرزاق السنية ليقصد كل من اختار علماً أو صناعة رئيس ما يختاره فيأخذ عنه ولو مد له في العمر حتى يفعل هذا لظهر فضل هذه الأمة على جميع الأمم ورجوت أن يكون في تناهي هذا الفعل وحده إلى سائر الاجيال والملل المخالفة للإسلام ما يفت في أعضادهم وينل من عزمهم ويصد عن الوثبة إذا فكروا فيها عزمهم هذا إلى ما كان يستمر بذلك من فيض الحكمة وعمومها إذا اعان الملك عليها والقوة الشريفة بما يتفق من وجوه البصر فيها مراماة
الاعداء والملحدين بالحجج البينة التي تزيل الشبة المضلة والتلاوات الباطلة التي بها ضل وعند من عند وبيان لجميع وجوه الحق ومذاهب الرشد وما كان يتفق به أيضاً من وجوه الصناعات التي يتخذ بها المكائد والآلات النافعة في محاربة أهل الجهل أن قصدوا البيضة وصدهم عنها باهون المساعي وأيسر المعاني والله يوفق أمير المؤمنين ويعينه على مصالح الأمة وحراسة الدين وان يرينا العدل شائعاً والقول به مستفيضاً ذائعاً بقدرته
ومما أذكره ليقبله الملوك ويأخذوا به أن أنوا شروان وقع إلى وزرائه بأن يسارعوا إلى ما يخرج أمره به من أمور الخير وأحواله من غير تربيت له ولا توقف عنه وان يسألوه عنه وليخبرهم بسببه فيكونوا هم أشد استبصاراً فيه وعلماً بحقيقة ما يمضي منه ويتوقفوا عما يخرج به أمره من الشرور حتى يراجعوه فيه أياماً ثلاثة ليتأمل ما أمره به منه حق تأمله ويستثبت فيه بما يستثبت به في مثله ويعمل بما يوجبه التأمل من امضائه أو التوقف عنه وهذه خليقة مع إنها شريفة موافقة لما توجبه الديانة وينفع مثلها في السياسة والمصلحة العامة
وأخبرني احمد بن يزيد المهلبي عن أبيه قال قلت للمعتمد على الله أن الكريم ينخدع فقال نعم ذاك إذا علم انه ينخدع فأما إذا ظن انه يخدع فلا يخلص المعتمد بقريحته وجودة خاطرة الكرم من الغباء تخليصاً بالغاً
ومما تكلم به البلغاء والملك محتاج إلى تقبله وان كانت احوال ما قاله هذا البليغ قد قدمنا حاجته إليها في موضعه فإن ما ذكره من فنون ذلك وفروعه هو قوله الكريم لا تغلبه الشهوة ولا يحكم عليه الشرة بسوءة ولا القدرة بسطوه ولا الفقر بذلة ولا الغنى بعزة ولا الصبر
بضجر ولا النعمة ببطر ومن شجاعة الملوك التي ينبغي أن توضع في مواضعها وقد قدمنا ذكر جملها ومعناها انه رفع إلى أنو شروان يسأل عن مبارزته العدو بنفسه فوقع لتشتهر في الأفاق شجاعتنا وتنتشر اخبارنا فيرهبنا عدونا وهذا القول مما ينبغي أن يسمعه الملك ولا يعمل في كل وقت به بل يفعله إذا حضر وقت يصلح له وحال يمكن فيها من الظفر بعدوه كما فعل الاسكندر بفور ملك الهند فإنه بارزه لما توجهت له المكيدة عليه ووثق من نفسه باستظهار في مبارزته فأما إذا لم يتوجه له ما يتقن الغلبة معه فينبغي أن يعمل الملك كما عمل المنصور مع ابن هبيرة وهو محاصر له بواسط أني خارج اليك يوم كذا وداعيك إلى المبارزة فأنه بلغني تجبينك أياي فأجابه المنصور عن هذه الرسالة بأن قال له يا بن هبيرة قد تعديت طورك وجريت في عنان غيك وسأضرب لك مثلاً يشاكل أمرك بلغني أن أسدا لقي خنزيراً فقال له الخنزير قاتلني فقال له الأسد لست بكفء لي لأنك خنزير ومتى فعلت الذي دعوتني إليه فغلبتك لم اكتسب بذلك ذكرا ولا نلق به فخرا وإن نالني شيء كان علي في ذلك سبه فقال الخنزير أن أنت لم تفعل رجعت إلى السباع فأعلمتها انك نكلت عني وضعفت عن قتالي فقال له الأسد احتمالي على كذبك ايسر علي من لطخ شاربي بدمك
ومما يحتاج الملك إلى التذكير به هو ما تقدم في باب الشهوات والاحتماء من الافراط فيها انه رفع إلى أنو شروان بأن الموكل بالمائدة وصف امساك الملك عما كانت تميل إليه شهوته من المطاعم فوقع تركنا ما نحبه لنستغني عن التعالج بما نكرهه وفي المثل السائر والقول الغابر اعجز العجزة من عجز سياسة نفسه وسئل بعض الحكماء فقيل له
أي الملوك أولى بالحزم فقال من ملك جده هزله وأعرب عن ضميره فعله ولم يخدعه رضاه عن حظه ولا غضبه عن كيده وقال آخر من الفلاسفة في صفة ملك بالحزم انه ينبغي إلا يبلغ من الشدة إلى ما يلحق معه الفظاظة ولا من اللين إلى ما ينسب معه إلى المهانة وهذا من جنس قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال أنه ينبغي للوالي أن يكون شديداً في غير عنف وليناً في غير ضعف ولعبد الملك ابن مروان فصل من كلام يحتاج الملوك إلى تقبله وهو قوله أن افضل الناس من تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة وانصف عن قوة
ومما يحتاج إليه الملوك ويزيد في قوتهم عليه التمهر في العلوم ومجالسة أهل الاداب والحلوم والحذق بالمحاجة ومقاومة ذوي الجدل عند المخاصمة فإنه يحكي عن المأمون انه قال لرجل من الخوارج أدخل إليه ما الذي حملك على خلافنا والخروج علينا فقال الخارجي آية وجدتها في كتاب الله قال قوله ( ^ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فقال له المأمون ألك علم بأنها منزلة قال نعم قال وما الدليل على ذلك قال إجماع الأمة فقال له المأمون فلما رضيت باجماعهم في التنزيل فأرض باجماعهم في التأويل فقال الخارجي صدقت والسلام عليك يا أمير المؤمنين فنجوع هذا الخارجي بالطاعة التي قاده إليها بالحجة احسن من غلبته بالقتال والحرب
ودخل ناس من أهل مصر على عتبة بن أبي سفيان فقال له انك سلطت السيف على الحق ولم تسلط الحق على السيف وجئت بها عشواء صفينية فقال لهم كذبتم بل سلطت الحق فتسلط معه السيف فاعرفوا الحق تعرفوا السيف قبل معرفتكم بالحق فإنكم الحاملون له حيث وضعه أعدل والواضعون له حيث حمله أفضل وأنتم في أول لم يأت آخره وآخر دهر قد مات أوله فصار المعروف عندكم منكرا والمنكر عندكم معروفا وإني لا أقول لكم مهلا قبل أن أقول لنفسي مهلا قالوا نخرج سالمين كما دخلنا آمنين قال غير راشدين ولا مهذبين
وقال أكثم بن صيفي وهو من خطباء العرب وحكمائهم كلاما يصلح للملوك أن يسمعوه وهو قوله اللبيب من حذر السقطة وحسن خروجه من الورطة وقال في موضع آخر الأديب من تجرع الغصة ووثب عند الفرصة ومما يصلح أن تعرفه الملوك ليتقبلوا أحسنه ويجانبوا اضره وأرذله ويتفهموا مواقع الرأي منه ما كان فالاسكندر ذو القرنين كتب به إلى أرسطا طاليس فإن الاسكندر كتب إليه يذكر أن في عسكره جماعة من خاصته وذوي حشمة وأهل الحزمة وأنه مع هذا لا يأمنهم على نفسه لما يرى من بعده همهم وقوة شجاعتهم وشدة دالتهم فإنه لا يجد لهم عقولا تفي بالفضائل التي فيهم ويكره الإقدام بالقتل عليهم بالظنة مع واجب الحرمة ويسأله عن الرأي في أمرهم فكتب إليه أرسطا طاليس فهمت كتاب الملك بما وصفه من أمر القوم الذين يضمهم عسكره فأما بعد هممهم فينبغي أن يعلم الملك أن الوفاء من بعد الهمة وان هذه الحال وإن كانت مرهبة ممن له من جهة إقدامه وإن كان يكله
إلى ناحية بسبب وفائه وأما ما يكره الملك من شجاعتهم ونقصان عقولهم عن الوفاء بها فمن كانت هذه حاله فره في معيشته وحوله حسان النساء يحبب السلامة وتباعد ركوب المخاطرة وليكن خلقك حسنا ستدع به صفو النية وخلوص المقة ولا يتناول من لذيذ العيش ما لا يمكن أوسط أصحابك تناول مثله فليس مع الاستئثار محبة ولا مع المواساة بغضة واعلم أن المملوك إذا استوى فليس يسأل من مال مولاه وإنما يسأل عن خلقه ففيما ذكرناه متعلم لأهل التأمل وذوي الروية والتبصير لأن فيه تبيانا عن صواب الرأي في مثل هذا الأمر إذا عرض وتعريفا لوجوب الإحجام عن قتل من يتهم بالظنين وترفيعا عما يوحي العزم ويحبب السلامة من الأسباب التي يستعمل أو تذكيرا لما يلزم من ترك الاستبداد برغد العيش على من يستصحب وإرشادا إلى أحسن الخلق مما يوجب أن يؤثر ولا يغفل وقالت حكماء الفرس أن الملك إذا صان وحرس كان فيه أربع خلال من الفضائل ويكون له من ثماني عوارض من الآفات يلحقها كثيرا وتتصل بها أبدا كان مستظهرا في أمره مستحقا لملكه موثقا لأركانه في جميع شأنه وهي النعمة من السكر والبطر وصحة الرأي من الجبن والفشل والقوة من البغي والعدوان والجرءة من السرف والاقتار الباب العاشر في الخلال التي ينبغي أن تكون مع خدام الملك والقرباء منه وهي عشرون خلة
أولها العقل فإنه رأس الفضائل وعنصر المحامد
الثانية العلم فإنه من ثمار العقل ولا تليق صحبة الملك أهل الجهل
الثالثة الود للناس فإنه خلق من أخلاق النفس يولده العدل في الإنسان لذوي جنسه
الرابعة النصيحة فإن الذي يبعث عليها إفراط الود كما أن العشق إنما يكون من إفراط الشوق
الخامسة كتمان السر وتولده في الإنسان من صدق الوفاء
السادسة العفة عن الشهوات والأموال
السابعة مجانبة الحسد وحدة الحسد شدة الغم مما يصل إلى أهل الفضل من الخير ومن الناس من يظن أن الحسد قد يكون محمودا بوجه من الوجوه وذلك حيث يقول منهم من يقول أن الحسد مذموم إلا في طلب العلوم والذي يقول ذلك فإنما يجعل المنافسة موضع الحسد والمنافسة في طباع البشر لأنها منازعة النفس نحو الفضائل من غير قصد الاضرار بالمنافس وغرض الحاسد اعدام من يحسده فضله وذلك مضر به
الثامنة الصرامة وهي شدة القلب فإنه لا يليق بصحبة الملوك أولي النكول ومن يلحقه في خدمتهم الفتور وعن الأمر يهاب به التقصير والجسور فإن الملك إذا كان على ما قدمناه من صفاته لم يجب لخادمه إلا النفاذ لجميع ما يأمره به لأنه من العقل بالموضع الذي لا يأمر بأمر إلا في حقه ولا يعرض من ينفذ لأمره لما لا خلاص له منه وقد كان عرض لذي القرنين في بعض حروبه أمر ندب له خاصته ومن كان يثق بمسارعته فنكل أكثرهم إلا رجلاً سارع إليه وقال قد وهبت نفسي للملك واثرت الموت في طاعته فقال له الملك فالان حين اشتد ضني بك وامتناعي من التغرير بك
التاسعة الصدق فإن مضرة الكذب على مستعمله وعلى من يقاربه غير يسيرة
العاشرة التغافل والصفح عن اكثر ما يوجب الغضب من أفعال لعلها تعرض إذا كان التفاعل عن ذلك غير ضائر
الحادية عشرة حسن الزي والهيئة فإن في بهاء الملك ورتبته
الثانية عشرة البشر والاجمال في الملاقاة ليتآلف صاحب الملك بذلك قلوب من يلاقيه ولا يخفيه باللكوح وبشاعة اللقاء من غير حادثة تكون من الملك ومنه
الثالثة عشرة أن يكون معه رأفة لا تصده عن امتثال أمر الملك في جميع ما يأمر به لأن الملك إذ قد وضع عادلاً فليس يجب أن يخالف في شيء مما يرسمه
الرابعة عشرة أن يكون مع كل صانع من أصحاب الملك نقية فيما يصنعه ويحده فأن النيقة سجية ربما وجدت في الناس وربما خلوا منها
الخامسة عشرة الأمانة فيما يستحفظ ورعاية الحق فيما يستودع
السادسة عشرة أن يكون في صبغته ايثار الأنصاف في المعاملة والعدل في المعاطاة والمؤاخذة فإن العدل يصلح السرائر ويجمل الظواهر وبه يخاصم الإنسان نفسه إذا دعته إلى أمر لا يجب أن يركبه وبالجور يكون في خليقة الإنسان الظلم يلتمس ما لا يجمل وجه التماسه إياه ويريد ما لا يعقل موضع ارادته وعند ذلك تضطرب مجاري السنن الحميدة وتنقص مذاهب السير السديدة
السابعة عشرة أن يخلو صاحب الملك من اللجاج والمحك فأن ذلك يضر بالافعال إذا وقع اشتراك فيها ومضامة من الجماعة عليها
الثامنة عشرة ألا يكون بذاخاً ولا متكبراً فإن البذخ من دلائل سقوط النفس والكبر من دواعي عمي القلب
التاسع عشرة ألا يكون حريصاً فإن الحرص من امارات ضيق النفس وشدة الطيش والبعد عن التماسك والصبر
العشرون ألا يكون فدما وخماً ولا ثقيل الروح فإن هذه الصفة غير لائقة بمن يلاقي الملوك وكثيراً مما يكون سبباً للمقت من غير جرم
وكان زياد بن أبي سفيان يقول ينبغي أن يكون خادم الملك ايقظ شيء عيناً وأخفه روحاً وأغظه طرفاً وأقله للناس سؤالاً فأن خادم الملك إذا سأل الناس وضع من قدر الملك ومما ينبغي لخادم الملك إذا كان حازماً أن يستشعره وهو أن يأخذ من أوقات منافعة الخاصة به ما يضيفه إلى وقت اشتغاله بخدمة الملك وأوامره فيأخذ من زمان طعامه وشرابه ونومه ومفاكهته وحديثه ولهوه ونسائه وسائر مآربه فيضيفه إلى ما ذكرته وقدمته إلا أن يخالف الحزم فيأخذ من أوقات اشغاله بمآرب الملك وحاجاته ولذاته ما يجعله مضافاً إلى مآربه في نفسه ولذاته فإن ذلك إذا فعله فاعل عاد بالتقصير فيما هو سبيله مما يقوم به وما جعل بصدده من أمور الملك وأسبابه وبالضرر عند الملك في حال نفسه ومكانته
وينبغي لخادم الملك إلا يطلب ما عنده بالمسألة ولكن بالاحسان في الخدمة والاجتهاد في الطاعة والمبالغة في النصح والكفاية فإن ذلك ولو تأخرت ثمرته اولى مما يجيء بالمسألة وان تعجلت فائدته وتوفرت عائدته لان ما يستثمر بالخدمة يأتي من عند الملك ونفسه به سمحة طيبة ويده بإعطائه سلسلة منبسطة والمسألة فإنما هي تذكره ما يأتي بها يأتي على سبيل استكراه ومنازعة وذاك مأمون الحاضرة والمغبة وهذا مخوف منه الاضجار والملالة
ومما ينبغي لخادم الملك أن يستشعره ترك الاعتداد بالبلاء الجميل يكون منه والتبجح بالكفاية البالغة التي من جهته بل ينبغي أن يكون بعد ما يظهر من جميل افعاله وحميد أحواله من التذلل للملك والاستخذاء
بين يديه على اشد من حال لم يبل مثل بلائه ولم يستوجب من الجزاء كجزائه لان من لم يكن له جميل اثر ولا محمود خبر فالثقة منصرفة إلى برأته من التبجح والاعتداد ومن أظهرت آثاره وبدأ احسانه وبلاؤه كان الظن منصرفاً إلى اعتداده به واستشعرت النفوس خفي ايمائه إليه واتكاله عليه
فينبغي لخادم الملك أن يداوي هذا الطريق ويقاومه ويبدي من الخضوع ما ينفيه ويجانبه ومما ينبغي لخادم الملك أن يكون صبوراً عليه وغير غضوب منه مما يباشره من مكاره ما يتلقاه بالمكاره بحضرته فإنه أن اظهر غضباً منها وبدا منه اكتراث لها صار الملك إلى حال اغراء بخصمه بالزيادة فيما يلقاه به منها وطرق على نفسه الاسترابة بسريرته فيها فإن كان ذلك مما يحتاج فيه إلى جواب فعلى سبيل الحلم والوقار لا على جهة الطيش والاستحقار فإن ذلك أثبت للحجة وأولى على كل حال بالغلبة والنصرة ومما يحتاج إليه خادم الملك أن لا يضمر فضلاً عن أن يظهر عيباً عليه ولا تكرها لشيء من أمره فإن أضمر ذلك ولم يمكنه الاغلب في نفسه اجتهد في كتمه وطيه وحذر من ظهوره في قوله وفعله وابانته في لحظه وشمائلة فإن فوثاغورس الفيلسوف يقول في وصيته المعروفة بالذهبية لا تعادوا الأمر الاغلب لا ظاهراً ولا باطناً وخطب المنصور فقال ما كأنه تفسير ما أدمجه فوثاغورس واوضحه وهو معاشر الناس لا تضمروا غش الأئمة فإن من أضمر ذلك اظهره الله على سقطات
لسانه وفلتات افعاله في سحنة وجهه ومما ينبغي لخادم الملك أن يستعمله مجانبة من يسخطون عليه وان كان منه قريباً ومفارقة من يظنون به ظن السوء وان كان إليه نسيباً فإنه إذا فعل ذلك فكأنه قد أثر أثراً استوجب به عندهم التقديم وان كان لم يليق بهذا الأثر نصيباً ولا تجشم بما استعمله منه كداً ولا تعباً وان قصر فيه فكأنه وان لم يذنب مذنب واستحق بذلك جرماً وان لم يكن مجرماً ومما ينبغي لخادم الملوك إلا يطغوا عند خصومهم بهم وتمكن أحوالهم منهم على أحد من نظرائهم ولا من منزلته دون منازلهم ولا يظهروا ترفعاً عليه ولا حدوداً عنه بل يكونوا مع اسباب المقاربة على مثل ما يكون عليه في احوال المباعدة وليجروا على سيرة واحدة وطريقة غير مختلفة مع الأحوال المتقلبة والاسباب المتغيرة فإن ذلك لو لم يكن انفع لكان احسن وإذا لم يكن احزم فهو اسلم ومما عنده من الجواب اصح مما عند الذي سأله وكذلك أن عم بالمسألة ينبغي أن يتحفظ منه خادم الملك إلا يجيب عما يسأل عنه غيره وان كان عنده من الجواب اصح مما عند الذي سأله وكذلك أن عم بالمسألة الجماعة فليس من الرأي للواحد منهم أن يبادر بالجواب حتى يشار إليه في نفسه ولعل الملك أن يؤثر امتحان من يسأله لينظر من منهم اولى بالخفة والاسراع إلى ما لم يقصد به من الجماعة فيكون المسارع عنده ناقص المعدلة ومستدعياً ممن يسبقه إلى القول من العصابة إلى أن يجعلوا وكدهم تطلب العيب لما يأتي وبه يكون المثبت متبحراً ما يجيب به من تقدمه ومتأملاً ما يتخذ التأمل من كلام يسمعه فيصح حينذاك التوقف والتمهل
احزم من الاسراع والتعجل ومما يجب على خادم الملك أن يستشعره وهو أن اغلاظاً أن أغلظه الملك في خطابه إياه فإنما أكثر ذلك لعزة الملك وحميته لا لعداوة ومقت يكونان في نفس الملك عليه فأنه إذا استشعر بهذا لم يعترض له تغير لما يجري منه ويخشى أن يكون مبغضاً عنده من أجله وممقوتاً لديه فتتحرك لذلك نفسه ويعرض له ما يعرض لمن كان في مثل طبيعته وانه إذا كان جباناً دخله ذل وهلع وان كان شجاعاً عارضه حمية وغضب فشيت هذه الأحوال إليه وأفسدت عليه ما هو بسبيله وإذا اضرب عنه صفحاً وقابلها بالاغضاء لما يستشعره من سببها هانت عليه واستقام معها أمره ومما يجب أن يتحفظ خادم الملك ويحذره أن يومى إلى إنسان بحضرته بمسارة أو يهمس إلى أحد بهمسة فإن ذلك في ظاهره لا يليق بمجالس الجلة وذوي الاقدار العالية إلى ما يتصل من وقوع الظنة وحدوث الريبة الباب الحادي عشر في أسباب بين الملك وبين الناس إذا تحفظ منها زادت محاسنه وانصرفت المعايب عنه وتمكنت له سياسته
من ذلك لا يؤثر المدح بل يكرهه ولا يتقبله بل يسيء متلقيه به ويزجره فإن الملك إذا وجد منه مثل ذلك الحال عاتبه وتوجهت المذام عليها وجعلها أهل الجهالات وعي الالسن طريقاً إلى خديعته وتسقطه وقابل المدح مع هذا قريب من مادح نفسه فإن كان في صيغة الملك حب المدح فليعلم أن كراهته له مجلبة لمدحه واستدعاءه إياه مدعاة إلى ذمة فليجتنب ما هو سبب إلى المدح وليتجنب ما هو داعية إلى الذم ومنه التوقي من أن يعن له فكر غير محمود في أن مشاورته في الأمر إذا شاور فيه افتقار منه إلى رأي غيره أو يأنف في بعض الاحايين من المشاورة فيما يعروه ويعرض له وليعلم عند ذلك انه ليس يريد الرأي ليتحدث به عنه بل إنما يريده للانتفاع بثمرته ولو انه كان يقصد بالمشورة أن يتحدث بها عنه لكان من الجميل أن يقال لا ينفرد برأيه بل يشارك ذوي الحجي والفضل فيه ويرجع إلى أهل الرأي فيما ينوبه منه وكل ذلك مع جماله وبهائه ما ينخب به قلوب اعدائه ويخوفهم بلوغ كيده وشديد مكره
وما ينبغي للملك أن لا يدع المشاورة ورسول الله لم يكن يدعها إلا فيما ينزل به الوحي أمر من أمر الله قاطع والرأي مجعول إلى الناس فيه التشاور وقد كان عليه السلام إذا أراد أمراً قال له أصحابه هذا بوحي من عند الله أم شيء أنت تفعله فيقول لو كان وحياً ما احتجت إلى نظر فيه ولكنه بالرأي فيقول كل امرئ منهم حينئذ ما عنده فلو أن احداً من البشر كان مستغنياً عن المشورة لاستغني عنها رسول الله ومع انه كان لا يستنكف عنها وقد أمر في القرآن أيضا بها فما لأحد أن يأنف منها ولا يضع نفسه موضع الاستغناء عنها ولم يكن أحد من الملوك الجلة إلا وله وزير أو وزراء يرجع إلى رأيهم فمنهم ذو القرنين الذي لم يبلغنا أن احداً ملك مثل ملكه من غير الأنبياء عليهم السلام فإنه كان يرجع إلى وزيره ومعلمه ارسطا طاليس في المشاورة ومن رسائله إليه في هذا المعنى رسالة كتب بها إليه بعد دخوله لبلاد فارس يستمده بها من الرأي ويستشيره فيما يكون عليه عمله من وجود التدبير يقول فيها أما بعد فإني راغب في المشورة وطالب الزيارة في المعرفة ومجتهد في الوصول إلى ثمراتها النافعة لا يثنيني عن ذلك رغبة اقدر مثلها ولا فضلية اتوهم الاعتياض بها ولعمري انه ليجب على من ولي مثل ما وليت
من الأمور وافضي إليه مثل الذي افضى الي من الأحوال أن يكون طالباً ثلاث خصال لا مذهب عنها أما الأولى فحقيقة الرئاسة واما الثانية فصرف التدبير إلى ما يلزم تدبيره واما الثالثة فاستعمال ذلك على جهته ووضعه في كنهه ولو كان طالب كل أمر يتأتى له ما يريده منه على سداده ويتوثق له ما يقدره فيه على حقه لم يكن الجهلاء محتاجين إلى العلماء بل كان يبطل اسم الجهل اصلاً إذ لم يكن يوجد إلا عالم ولا كان أيضا قدر ولا خطر ولا كان لأحد فضل بالتمييز لتساوي الناس جميعاً في ذلك لأنه إذا كان المدح لازماً لأهل الفضل بغضهم فالذم واجب على ذوي الجهل بجهلهم وقد قال بعض الحكماء أن الحكمة تطلب لاستحقاق اسمها ولأن ننفي عن طالبها اسم الجهل بها وقد قال أفلاطون كل من التبس عليه شيء من العلم فاليسأل عنه أهل المعرفة فإنه بذلك يستحق اسم الحكمة ويستوجبه وبتركه إياه وعدوله عن طلبه من أهله يلزمه اسم الجهل ويستحقه
ذكر الاسكندر في هذه الرسالة اموراً أخر ليس هذا موضع ذكرها إلى أن قال فيها ولو كان أحد مستغنياً برأيه عن المشورة لكان اوسطاثيوس جديراً بذلك لما كتب سيذروس الملك يسأله عما يعمل به في أهل اتليس واسطوغورس وهاتان مدينتان ظفر بأهلها فلما لم يكن عنده فيما يسأل عنه من الرأي ما يرضاه رجع إلى مشاورة الفلاسفة وأهل الحكمة ووجه إلى سوان يسأله عما سأل عنه من الرأي فوضع سوان في ذلك الكتاب المرسوم بكتاب الصفح فوجه به اوسطاثيوس إلى سيذروس الملك وكتب إليه بحقيقة خبره وانه لما لم يثق بما عنده رجع إلى سوان
فيه لسنه وكثرة تجاربه فحسن وضع ذلك عند سيذروس وعمل بما فيه ثم قال الاسكندر بعد هذا مخاطباً لارسطا طاليس واما بعد فإنه قد يجب أن احل نفسي مع هذا الخطب المحل الذي توجبه الطبيعة لانه من أراد معرفة شيء من الأمور فلا محالة أن يطالبه عند أهله فإنا نجد ذلك كثيراً في أصحاب المهن والصناعات وقد احتجت إلى أن يتبين لي ما اجتلب به مصلحة اموري في الرعية واصلاحها عندي حتى يكون قد ذهبت بالمكرمة الأولى وحصلت فضل الأخرى وتمت لك نعمة الفوز في العقبى وقد قال ادميوس الشاعر كل من سن خيراً بقى له ذكره ولا خير فيمن سن الشر وأنت بالموضع الذي احلك الله به وجعلك أهله من الحكمة والفضل على كل حال فتقدم باجابتي وليكن ذلك في كتاب مشروح لاجعله نصب عيني والتمس به حسن الأثر الباقي على الدهور ويكون قد سدت بفضل الحكمة والعلم قديماً وحزت شرفها حديثاً فعلى حب الحكمة فليكن اجابتك والله أسأل الامن من الفجيعة بك
فكتب إليه ارسطا طاليس رسالته المسماة برسالة التدبير وقد ذكرنا بعض ما تضمنت ونحن نذكر باقيها في مواضعه إنشاء الله ولا ينبغي للملك أن يظن انه من الجائز أو السائغ ارضاء جميع رعيته إذ كان متعذراً ذلك فيهم لاختلافهم وتباين صيغهم ومذاهبهم ولان فيهم ارضاه الجور والخبال وفي اتباع مراده بالباطل والضلال وفي وقاية البلاء والفساد بل ينبغي أن يكون وكده رضا الاخيار وأهل الفضائل فإنه متى توخي ذلك واعتمده عفى على ما سواه واصلحه وكان اكثر ما يرتئيه صواباً وأكثر
ما يعتمده أو جله مستحسناً مقبولاً وليحرص الملك كل الحرص على أن يكون خبيراً بأمور رعيته فإنه عند ذلك يخاف المسيء من خبرته قبل أن تنزله عقوبته ويستشرف المحسن مثوبته قبل ما يستحق ذلك بسبببه وليجتهد الملك أكثر الجهد أن يتمكن في نفوس أهل مملكته أنه لا يعجل بثواب ولا يبادر بعقاب ليدوم رجاء الراجي له وخوف الخائف منه ويكبر في نفوس الرعية خطره ويعظم لديهم شأنه وليحسن الملك تدبير أمره فلا يدع ملابسة كثيرة لئلا يقع فيه الخلل والتضييع ولا يباشرن صغيرة لئلا يرى بعين المهانة والتحقير بل يكون معايناً للأخص مطالعاً للأعم يقرب في تباعد ويبعد في تقارب حتى تتعادل أحوال ما يرعاه ويدبره ويوازن أصناف ما يكلائه ويعني به وليس يجب أن يكون الملك نزر الكلام ثقيل الطرف عند رد السلام ولا كثير النظر سريع الرد بل في الوسط من الحالين وفيما بين المنزلتين لئلا ينسب لى كبر ولا طيش ولا اعجاب ولا سخف وليدع الملك اليمين والحلف مصرحاً أو معرضاً فإن اليمين من الحالف بها إنما تكون على أحد وجهين أما الاجتهاد في أن يصدق فيما يقوله وليس الملك مضطراً إلى ذلك في حال من أحواله أو من عي اللسان وحاجته أن يستريح منه إلى الإيمان وهذا أيضا غير لائق بالملك لأنه من العورات التي أن لم تكن بهم فقد كفاهم الله قبحها وان كانت فتحت عليهم طينها وسترها ومما يحتاج إليه الملك معرفة أهل الديانات الوثيقة والنيات السليمة والمروءات الصحيحة فيتخذهم اعوانه وخلصائه وثقاته ويجعلهم شعاره وبطانته فإنه إذا توخى ذلك واعتمده ولم يدخله غلط فيه حسنت أحواله كلها واستقامت افعاله وطهرت سريرته ونظفت علانيته
ومما يجب على الملك الاجتهاد في رياضة نفسه على كتمانه أن يبدو في وجهه الغم أو الغيظ أو الرضا أو الفرح آثار يعرف بها ما عنده منها فإنه لا عيب على الملك أعيب من أن يوقف على ما في نفسه من غير ارادته ويطلع على ضميره من غير اختيار فإن ذلك مما لو باح به إلى إنسان فنمه واطلع عليه أحداً فباح به لوجبت معاقبته عليه فكيف به إذا ترك التحرز من حال يعاقب عليها غيره ويتصور من أمر لا يرضاه من سواه وهذا أيضا مما إذا قوى الإنسان على ضبطه وتأتي للتحفظ منه دل على حصانته وابان عن رجاحته وأنبأ عن بعد الديانة فيما يأخذ به ويعطي ويحكم به ويقظي لم يكن ملوماً ولا مذموماً ولو بلغ من العقوبات غاياتها ومن الأمور الشاقة إلى غاياتها وإذا عدل عن ذلك من احسان وترفيه واجمال فيما يأخذ به لم يسلم من عائب يتوجه له من عيبه ما لا ينكره لكثر الناس ولا يرون مخالفته ولو ذهب واحد من الناس أن يعيب الملك وهو على سنن الشريعة كان كالعائب لهم جملة والراد لما في أيديهم عامة فليلزم الدين الذي هو أس لملكه وعمادة لسلطانه ولا يلتفت إلى ما سواه من إجمال يعتمده واحسان يقصده وهو مخالف للدين وغير موافق له وليراع الملك فيما يراعيه من أمور رعيته خلة الكريم وفاقته وليحرص على ذلك منه وازالته وكذلك فليتأمل بطر السفلة بالجدة وطغيانهم بالثروة وليقصد لابطال ذلك وقمعه وازالته وحسم سببه فإن من الأمثال السائرة والوصايا السالفة انه ينبغي أن يستوحش من جوع الكريم وشبع اللئيم
وليعلم الملك أن أول وهاء ملكهم وأكبر آفات دولهم إنما هو ارتفاع السفلة الذي هو سبب انحطاط الاشراف والعلية فإن من الأمثال السائرة والحكم الغابرة أن انحطاط مائة من العلية احمد من ارتفاع واحد من السفلة والسبب في ذلك أن اللئيم الناقص المعرفة والوضيع المنبت والابوة ارتفعت به حال أو علت به رتبة كان احتباوه لمن يقرب من حاله في الخلال التي عددتها أشد واشتماله على من ما يله فيها أو كد وكلما اجتمعت إليه من مثل هذه الطبقة عصابة فاضت بهم الجهالات وانتشرت واثمرت بذلك الحساسات وانبسطت وكلما زاد واحد من هذه الفرقة ضرب إليه من جنسه جماعة لم يجتبوا أيضا إلا أمثالهم في السقوط والضعة وقلة المعرفة فحازوا المراتب دون من يستوجبها من أهل الفضل والنفاسة وذوي الاداب والدراية ومع الجهل سقوط المراتب كما انه مع العقل ارتفاع الدرج والمنازل وفي الإنسان إذا تؤمل آمره مع سائر أنواع الحيوان بيان ومعتبر لأنه إذا وجد الإنسان في صغر جدعته وتعرى جلده ونقص قوته وأيده وعدمه السلاح المعد للبطش في جسده يغلب البعير والفيل حتى يستخدمهما والاسد والنمر حتى يذللهما وينتفع بهما وكذلك سائر الحيوان يصرف انواعها على ما يختار منها لم يكن للغلبة وجه إلا ما أعطيه الإنسان من التمييز والحكمة وانه مخول منهما ما ليس لغيره من الحيوان مثله وانه كلما غلب الإنسان الحيوانات غير المميزة بالتمييز فكذلك يغلب من كان من الناس اقوى تمييزاً لذوي ضعف التمييز ويستولي منهم من كان أنفذ في المهم والتدبير على من كان أضعف في ذلك من الجميع فقد وضح الدليل وصح البرهان على أنه مع العقل والحكمة الغلبة ومع الجهل والسقوط والانقياد والذلة وصدق المثل القديم في ارتفاع واحد من السفلة
يغلب الجهل الذي هو سبب زوال القهر والغلبة وانحطاط المراتب العالية وقد قال بعض الحكماء من الفرس قولاً لم يأت ببرهانه كما بينا إلا أنا ذكرناه لما كان لما قلناه موافقاً وهو إذا سادت السفلة انحطت السراة وإذا انحطت السراة ولى الزمان وإذا ولي الزمان نزل البوار وقال بعض حكماء الهند في مثل ذلك أيضا أفضل الازمنة ما لم تكن الغلبة والاستئثار فيه للئام والسفلة ومن اصطفى الاشرار استوجب البوار
وقال بعض بلغاء العرب في مثل ذلك أيضا مقارنة السفلة تميت الهمم والنباهة وتفسد اللسان والعبارة وتصدى الطبع والقريحة وتبعث على لؤم العادة واقتناء الاخلاق الدنيئة الرذيلة وتسقط من أعين السراة وذوي الفضيلة
وقال الافوه الاودي الشاعر في هذا المعنى ما دل على ما موافقته بما عن له وجرى على لسانه حكم العرب والعجم التي بيناها والبراهين التي أوضحناها الباب الثاني عشر في استيزار الوزراء وما يحتاج إليه الملوك منهم وما يلزم الملوك لهم
أن أفضل الوزراء من يدين بحياة الملك وطاعته ويسخط العالم في سبيل مرضاته ويذهب نفسه وماله في ارادته ويجب أن يكون في الوزير هذه الخصال
أولها أن يكون تام الاعضاء تواتيه على الأعمال التي من شأنها أن تكون بها ومنها
الثانية أن يكون جيد الفهم كثير العلم حسن التصور ربما يقال حساساً دراكاً يقظان فطناً متغافلاً مستمعاً إذا رأى على الأمر اقل دليل فطن له على الجهة التي قصدته
الثالثة أن يكون جميل الوجه حسن العقل غير صلف ولا ذي قحة
الرابعة أن يكون حسن العبارة يواتيه لسانه على ما في قلبه ويميزه بأوجز الالفاظ
الخامسة أن يكون حسن الملبس ناقداً في كل علم لا سيما علم الحساب فهو العلم الحقيقي البرهاني الذي يهذب الطبع
السادسة أن يكون صادق القول محباً له مجانباً للكذب حسن المعاملة كريم الخلق لين الجانب سهل اللقاء
السابعة أن يكون قنوعاً في الاكل والشرب قليل الشهوة في النكاح متجنباً للذات المزاح
الثامنة أن يكون كثير اليقين عالي الهمة محباً للإكرام كارهاً للضيم
التاسعة أن تكون الدنانير والدراهم وسائر اغراض الدنيا هينة عليه ولا تكون همته إلا فيما يقيم به جاه رئيسه ويحببه إلى الناس
العاشرة أن يكون محباً للعدل وأهله مبغضاً للجور والظلم يعطي النصفة لأهلها ويرثي لمن حل به الجور ويمنع منه ولا يمنعه من ذلك مساعدة أحد من خلق الله
الحادي عشر أن يكون قوي العزيمة على الشيء الذي ينبغي أن يفعله غير خائف ولا ضعيف النفس ثابت القلب يحسن الفروسية ومباشرة الحرب
الثانية عشر أن يكون كاتباً مرسلاً خطاطاً أديباً حافظاً للتواريخ وايام الناس وسير الملوك واخبار المتقدمين من الأمم الماضية وان يكون عالماً بخرجات الملك كلها لا يخفي عليه وجه من الوجوه فإذا علم أهل الخدمة أن الوزير عالم بالخدمة لم يقدموا على ادخال داخلة
الثالثة عشر أن لا يكون كثير الكلام مهذاراً كثير المزاح والتعريض بالناس والاستخفاف بهم
الرابعة عشر أن لا يكون ممن ينهمك في الشراب والراحات واللذات ويكون ليله كنهاره في لقاء الناس ومباشرة الجماعات وحسن النظر والتدبير ويكون محله موطناً للصادر والوارد من ذوي الحاجات مصغياً إلى أخبارهم مصلحاً لجميع امورهم مؤنساً لوحشتهم صابراً على تحاملهم ويكون ممن يعتقد الربوبية ومن يوثق بناموسه ويعتقد شرائعه
جملة ما يلزم الوزراء من الحقوق لملوكهم ثلاثة الاخلاص في النصيحة وبذل الجهد في اقامة صحة المملكة ودفع الآفات عنها
واما تفصيل ذلك فهي حقوق متعددة منها مستحبة ومنها متأكدة ومنها الاخلاص في النصيحة والود فلا يضمر له غشاً ولا يدخر عنه مالاً ولا نفساً ولا يداجي عليه عدواً ولا يطوي عنه نصيحة يحتاج إلى اعلامه بها
منها اظهار محاسنه أن خفيت ونسبة افعال الخير إليه وستر مساوئه أن ذكرت وتتبع من يخالف ذلك حتى يزيله عنه أما بقمع أو باحسان
ومنها التواضع له والاجلال لقدره في الحضور والغيبة وقد قيل كلما زادك الملك اكراماً فزده تواضعاً ويتقاصر فيما يضاهيه من تجمل أو تنعم أو مقاربة في مسكن أو مركب أو ملبس أو حشم وإذا فهم أن له غرضاً في شيء مما عنده تركه له
ومنها تنفيذ اوامره بعد أن يتأملها فأن رأى خللاً سده أو خاف مكروهاً سعى في ازالته والادب في ذلك أن يجيب بالسمع والطاعة ويوقف الامضاء بنوع من التعاويق ثم يراجع الملك على خلوة فإن تعذر فبمكاتبة ويوضع ما ظهر له من الرأي وما يخشاه من الخلل ثم يعمل بما يوافقه عليه ويقرره معه
قال أفلاطون أول أدب الوزير و رياضته أن يتأمل اخلاق الملك فإن كانت شديدة عامل الناس باللطف ولين الجانب وان كانت لينة عاملهم بقوة وصرامة غير مفرطة ليعتدل التدبير
ويقال أن معاوية كتب إلى زياد ليكن بيني وبينك في سياسة الرعية شعرة ممدودة أن شددت طرفها فأرخها وان أرخيت طرفها فأشددها فإنا أن شددنا جميعاً انقطعت
وسبب هذه الرسالة أن بعض امراء العرب نقم عليه معاوية فأبعده فسار إلى زياد فقبله وأنزله ثم خاف من انكار معاوية عليه فأرسل يستأذنه في أمره فأجابه بهذا الجواب
ومنها تعجيل عطاياه واوامره سيما إذا علم اعتناءه به أو تأكيده الوصية في حقه وكذلك يجب تعجيله ما يطيق لولاة الثغور والحروب والفيوج والرسل فإن هذه أمور أن أخرت عن أوقاتها كثرت مضراتها والملوك تغضب لرد اوامرها وتوقيف اعطياتها وهباتها إلا إذا كان الوزير ممن قد فهم أن مراد الملك التوقف فليمطل ولا يشعر احداً بأنه رأى الملك فإنه لؤم لا ينسب إليه
ومنها السعي في عمارة البلاد واصلاح خللها وتثمير الأموال والمزروعات وتحصيل آلات العمارة والترغيب في ذلك فإن بالعمارة تغزر الأموال وبالأموال تشمخ الممالك وتكثر الاعوان
ومنها حسن النظر في أمر الجند فلا يؤخر عنهم العطاء ولا يلجئهم إلى الشغب والغوغاء ويسوسهم بما يديم طاعتهم ويؤلف كلمتهم وقد بنيت سياسات الجند في كتابي في الحروب
وإذا اعتدلت سياستهم استقامت مع الملك سيرتهم وأمنت مضرتهم
ومنها القيام بصالح الملك الخاصة في ترتيب آلاته ودوره ومطابخه ونفقات غلمانه وحشمه ودوابه فلا يكون في ذلك توقف ولا تقصير وكذلك لا يغفل عن أمر حراسه الملك وحفظه وان يندب لذلك من يوثق
به ولا يغفل عنه في ليل ولا نهار ولا في أوقات نومه ويقظته وخلوته سيما في وقت انسه وسكره فإن ذلك مما يجب أن يمعن فيه النظر ولا يتساهل فيه
وبلغني أن المأمون خرج في عشية يوم من مقصورته إلى الدار المعروفة بدار العامة فرأى الحسن بن سهل جالساً فيها ينظر في الأعمال وينفذ الاشغال فسأل عنه فقيل انه من الصبح هنا ولم يمض إلى منزله فلما رآه الحسن قام مبادراً إلى بين يديه فقال تعبت اليوم يا أبا الفضل فقال لا أعد تعباً ما كان لراحة أمير المؤمنين وفي خدمته فاستحسن منه الجواب
وقال عبد الحميد الكاتب أتعب قدمك فكم قدم قدمك
ومنها أن لا يعارضه في خواصه وبطانته ولا في حرمه واصاغره فإنه إليه أميل وهم عليه أقدر ولا يستكثر لهم العطاء ولا يمطلهم في الصلات والحباء فإن كان فيهم من يشين الملك تقريبه أو يخاف غائلته فيتلطف في ايصال ذلك إليه على لسان غيره أو يعرض به في ضمن الحكايات والاشارات دون التبكيت والتعبير حتى لا يتمقت إليه بإبطال اغراضه وتنغيص مسراته فكم قد عادت هذه بمضرات على قائليها حيث لم يتلطفوا فيها
ومن حقوق الوزراء على الملوك منها أن يمكنه من التصرف ويحكمه في التدبير أن كان وزيراً مطلقاً حتى تنفذ تصرفاته وتستقيم سياساته
ومنها أن يرفع من قدره وينوه باسمه بما يتميز عن أبناء جنسه بتشريفه في ملبسه ومركبه وموكبه ومجلسه وفي تلقيبه وتكنيته على ما تجري به عادة اصطلاح أبناء الزمان
ومنها أن لا يسمع كلام الوشاة والمتعرضين فإنه مقصود ومحسود والحسود لا يبقى ولا يذر بل يجب أن يعرض له بما بلغه عنه مما يكرهه أو يستصوبه فإن كان صحيحاً اعتذر ولم يعد وان كان كذباً وتمويهاً برهن عن نفسه ليزول الشك فيه
قال المتوكل لاحمد بن أبي دؤاد قد رفعت الي سعايات في حقك فقال لا عجب أن احسد على مكاني من أمير المؤمنين
وقال بعض حكماء الفرس على الملك لوزيره أربعة حقوق هي أن لا يؤاخذه بغير حق ثابت ولا يطمع في ماله بغير خيانة ولا يقدم عليه من هو دونه بالكفاية ولا يمكن منه عدواً
ومنها المشورة في الأمور وهي وان كانت مشتركة بين العقلاء إلا إنها بالوزراء الزم
قد تم كتاب الخراج في غرة شهر ربيع الأول في دار العلية الاسلامية في بدء قبل الخليقة بن مرزا محمد الخوئي
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير