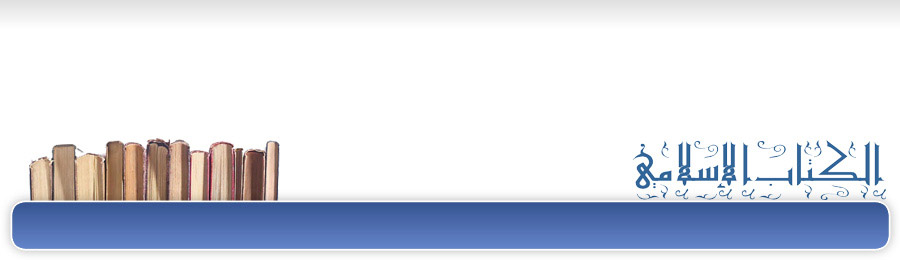كتاب : دلائل الإعجاز
المؤلف : أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني
أن نتبعَ ما قدَّرناه نفي الاثنين ولا يصحُّ لهم . تفسيرُ ذلك أنَّه يصحُّ أن تقول : " ولا تقولوا لنا آلهةٌ ثلاثةٌ ولا إلهان " لأَنَّ ذلك يَجْري مَجْرى أن تقول : ليس لنا آلهةٌ ثلاثةٌ ولا إلهان وهذا صَحيحٌ . ولا يصحُّ لهم أن يقولوا : " ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة ولا إلهان " لأنَّ ذلك يجري مَجْرى أن يقولوا : ولا تقولوا آلهتنا إلهان وذلك فاسدٌ فاعرفْه وأحسِنْ تأمُّله
ثم إنّ هاهُنا طريقاً آخر وهو أن تقدِّر : ولا تقولوا اللهُ والمسيحُ وأمُّهُ ثلاثة . أي نعبدُهما كما نعبدُ الله . يبيِّنُ ذلك قولُه تعالى : ( لَقد كَفَرَ الذينَ قالُوا إنّ اللهَ ثالثُ ثلاثةٍ ) . وقد استقرَّ في العُرف أنهم إذا أرادوا إلحاقَ اثنينِ بواحدٍ في وصفٍ من الأوصاف وأنْ يجعلوهما شَبيهين له قالوا : هُم ثلاثة . كما يقولون إذا أرادوا إلحاقَ واحدٍ بآخر وجعلَه في معناه : هما اثنان . على هذا السبيل كأنهم يقولون : هم يُعَدّون مَعَدّاً واحداً . ويوجِبُ لهم التِّساوي والتشارُكَ في الصفة والرتبة وما شاكل ذلك
واعلمْ أنه لا معنى لأن يُقال : إنَّ القولَ حكايةٌ . وإنه إِذا كان حكايةً لم يلزم منه إثباتُ الآلهة لأنه يجري مَجرى أن تقولَ : " إنّ من دين الكفارِ أن يقولوا الآلهة ثلاثة " . وذلك لأن الخطابَ في الآية للنصارى أنفسِهم ألا ترى إلى قوله تعالى : ( يا أَهْلَ الكِتابِ لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إلاَّ الحَقَّ إنّما المَسيحُ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وكَلِمَتُهُ أَلْقاها إلى مَرْيمَ ورُوحٌ مِنْهُ فآمِنُوا باللهِ ورُسُلِه ولا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ ) . وإِذا كان الخطابُ للنصارى كان تقديرُ الحكاية مُحالاً ف " لا تقولوا " إذاً في معنى لا تعتقدوا . وإِذا كانَ في معنى الاعتقاد لَزِم إذا قدَّر " ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة " ما قلنا إنه يَلْزَم من إثباتِ الآلهة وذلك لأن الاعتقاد يتعلَّق بالخبر لا بالمُخبَر عنه
فإِذا قلتَ : لا تعتقدُ أن الأمراء ثلاثةٌ نهيتَهُ عن أنْ يعتقَد كونَ الأمراء على هذه العدَّة لا عن أن يعتقد أن هاهنا أمراء . هذا ما لا يشكُّ فيه عاقلٌ وإنَّما يكون النهيُ عن ذلك إذا قلتَ : لا تعتقد أن هاهنا أمراء لأنك حينئذٍ تصيرُ كأنك قلت : لا تعتقدُ وجودَ أمراء . هذا ولو كان الخطابُ معَ المؤمنين لكان تقديرُ الحكاية لا يصحُّ أيضاً . ذاك لأنه لا يجوزُ أن يقالَ : إنَّ المؤمنين نُهوا عن أن يَحكوا عن النصارى مقالَتَهم ويخبروا عنهم بأنَّهم يقولونَ كيتَ وكيتَ . كيف وقد قال الله تعالى ( وقالتِ اليهودُ عُزيرٌ ابنُ اللهِ وقالتِ النصارَى المَسيحُ ابْنُ
اللهِ ) . ومنْ أينَ يصحُّ النهيُ عَنْ حكايةِ قولِ المُبْطِل وفي تركِ حكايته تَرْكٌ له وكفرٌ وامتناعٌ منَ النَفْيِ عليه والإِنكارِ لقوله والاحتجاجِ عليه وإقامة الدليل على بُطلانه . لأنه لا سبيلَ إلى شيءٍ من ذلك إلاّ من بعد حكايةِ القولِ والإِفصاحِ به فاعرِفْه
بسم الله الرحمن الرحيم فصل
في أن الفصاحة في اللفظ لا المعنى
قد أردنا أن نستأنِفَ تقريراً نزيدٌ به الناسَ تَبصيراً أنَّهم في عمياءَ من أمرِهم حتَّى يسلكوا المسلَكَ الذي سلكناه ويُفْرِغوا خواطِرَهُم لتأمُّلِ ما استخرجناه وأنَّهم ما لم يأخذوا أنفسَهم بذلك ولم يُجرِّدوا عناياتِهم له في غرورٍ كمن يَعِدُ نفسه الريَّ من السَّرابِ اللامِعِ ويخادعُها بأكاذيبِ المطامعِ . يقال لهم إنكم تتْلون قولَ اللهِ تعالى : ( قَلْ لئَن اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ والجِنُّ على أن يأتُوا بِمثْلِ هذا القرآنِ لا يأتُون بِمِثْله ) وقولَه عز و جلَّ : ( قُلْ فأتُوا بَعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ ) وقولَه : ( بسُورةٍ مِنْ مثْلِه ) . فقالوا : الآن أيجوزُ أنْ يكونَ تعالى قد أمرَ نبيَّه بأنْ يتحدَّى العربَ إلى أن يُعارضوا القرآنَ بمثلِهِ من غيرِ أن يكونوا قد عَرَفوا الوصفَ الذي إذا أتَوا بكلامٍ على ذلك الوصفِ كانوا قد أَتَوا بمثلِه ولا بُدَّ من " لا " لأنَّهم إنْ قالوا : يجوزُ أبطلوا التحدِّي من حيث إنَّ التحدي - كما لا يخفى - مطالبةٌ بأن يأتوا بكلامٍ على وصفٍ ولا تصحُّ المطالبةُ بالإِتيان به على وصفٍ من غيرِ أن يكونَ ذلك الوصفُ معلوماً للمطالَبِ ويبطلُ بذلك دعوى الإِعجاز أيضاً . وذلك لأنه لا يتصوَّر أن يقالَ : إنه كانَ عَجْزٌ حتى يثبتَ معجوزٌ عنه معلوم . فلا يقومُ في عَقْل عاقلٍ أن يقول لخصمٍ له : قد أعجزَك أن تفعلَ مثلَ فعلي . وهو لا يشيرُ إلى وصفٍ يَعلَمُه في فعله ويراهُ قد وقعَ عليه . أفلا تَرى أنَه لو قالَ رَجلٌ لآخرَ : إني قد أحدثتُ في خاتَمٍ عملتهُ صنعةً أنتَ لا تستطيعُ مثلَها لم تَتَّجه له عليه حجةٌ ولم يثبُتْ به أنه قد أتى بما يعجزُه إلاّ من بعدِ أن يرِيَهُ الخاتمَ ويشيرَ له إلى ما زعمَ أنه أبدعَه فيه منَ الصَّنعة لأنه لا يصحُّ وصفُ الإِنسانِ بأنه قد عَجزَ عن شيءٍ حتى يريدَ ذلك الشيءَ ويقصدَ إليه ثم لا يتأتَّى له . وليس يتصوَّرُ أن يقصِدَ إلى شيءٍ لا يعلَمُه وأن تكونَ منه إرادةٌ لأمرٍ لم يعلمْه في جملةٍ ولا تفصيلٍ
ثم إنَّ هذا الوصفَ ينبغي أن يكونَ وصفاً قد تجدَّد بالقرآن وأمراً لم يوجَدْ في غيرهِ ولم يُعرَفْ قَبْلَ نزوله . وإِذا كان كذلك فقد وجبَ أن يعلمَ أنَّه لا يجوزُ أن يكونَ في الكلم المفردةِ لأنَّ تقديرَ كونهِ فيها يؤدِّي إلى المحالِ وهو أن تكونَ الألفاظُ المفردةُ التي هي أوضاعُ اللُّغة قد حدَثَ في حَذاقة حروفِها وأصدائها أوصافٌ لم تكن لتكونَ تلك الأوصافُ فيها قبل نزولِ القرآن وتكونَ قد اختصَّتْ في أنفسِها بهيئاتٍ وصفاتٍ يسمعُها السامعون عليها إِذا كانتَ متلوَّةً في القرآن لا يجدون لها تلك الهيئاتِ والصفاتِ خارجَ القرآن . ولا يجوزُ أن تكونَ في معاني الكلم المفردةِ التي هيَ لها بوَضْعِ اللغة لأنه يؤدي إلى أن يكونَ قد تجدَّد في معنى الحمدِ والربِّ ومعنى العالمينَ والمُلك واليومِ والدِّين . وهكذا وصفٌ لم يكن قبلَ نزول القرآن . وهذا ما لو كان هاهُنا شيءٌ أبعدُ من المُحال وأشنعُ لكان إيَّاه . ولا يجوزُ أن يكون هذا الوصفُ في تركيبِ الحركات والسَّكنات حتى كأنَّهم تُحُدّوا إلى أن يأتوا بكلامٍ تكون كلماتُه على تَواليها في زنةِ كلماتِ القرآن وحتى كأنَّ الذي بانَ به القرآنُ من الوصفِ في سبيل بَيْنونةِ بحورِ الشعر بعضِها من بعضٍ لأنه يخرجُ إلى ما تَعاطاهُ مُسيلِمَةُ من الحماقة في : إنا أعطيناك الجَماهر فصلِّ لربِّك وجاهِرْ والطَّاحناتِ طحنا
وكذلك الحكمُ إنْ زعم زاعمٌ أن الوصف الذي تُحُدُّوا إليه هو أنْ يأتوا بكلامٍ يجعلونَ له مقاطعَ وفواصلَ كالذي تراه في القرآن لأنه أيضاً ليس بأكثرَ من التَّعويلِ على مراعاةِ وَزنٍ . وإنَّما الفواصلُ في الآيِ كالقوافي في الشعر . وقد عَلِمْنا اقتدارَهم على القوافي كيف هوَ . فلو لم يكنِ التحدِّي إلاّ إلى فصولٍ منَ الكلام يكونُ لها أواخرُ أشباهِ القوافي لم يُعْوزهم ذلك ولم يتعذَّر عليهم . وقد خُيِّل إلى بعضِهم - إنْ كانت الحكايةُ صحيحةً - شيءٌ من هذا حتى وضعَ على ما زعموا فصولَ كلام أواخِرُها كأواخرِ الآيِ مثلَ يعلمون
ويؤمنون وأشباهَ ذلك . ولا يجوزُ أن يكونَ الإِعجازُ بأن لم يُلْتَقَ في حروفهِ ما يثقلُ على اللسان
وجملةُ الأمرِ أنّه لن يعرِضَ هذا وشبههُ من الظنون لمن يعرِضُ له إلاّ من سوءِ المعرفة بهذا الشأن أو للخُذْلان أو لشهوةِ الإِغرابِ في القولِ . ومَنْ هذا الذي يرضى من نفسهِ أن يزعمَ أنَّ البرهانَ الذي بانَ لهم والأمْرَ الذي بهرَهم والهيئةَ التي ملأتْ صدورَهم والرَّوعةَ التي دَخَلت عليهم وأزعجتْهم حتَّى قالوا : " إنَّ له لحلاوةًوإنَ عليه لطُلاوةً وإن أسفَله لمُغْدِقٌ وإنَّ أعلاه لمثمر " . إنما كان بشيءٍ راعَهم من مواقعِ حركاته ومن ترتيبٍ بينَها وبين سَكناتهِ أو لفواصلَ في أواخرِ آياته من أينَ تليقُ هذه الصفةُ وهذا التشبيهُ بذلك أم ترى أن ابنَ مسعودٍ حين قال في صفةِ القرآن : " لا يَتْفَهُ ولا يَتَشانُّ " وقال : " إِذا وقعتُ في آلِ حم وقعتُ في رَوضات دَمِثاتٍ أتأنَّقُ فيهم " أي أَتتبَّع محاسنَهن . قال ذلك من أجلِ أوزان الكلمات ومن أجل الفواصلِ في أواخرِ الآيات أم ترى أنهم لذلك قالوا : لا تفنى عجائبُه ولا يَخْلقُ على كثرة الردِّ أم ترى الجاحظَ حين قال في كتابِ " النبوَّة " : " ولو أن رجلاً قرأ على رجلٍ من خطبائِهم وبلغائِهم سورةً واحدةً لتبيَّنَ له في نظامِها ومَخْرجِها من لفظِها وطابعها أنه عاجزٌ عن مثلِها . ولو تُحدِّيَ بها أبلغُ العرب لأظهرَ عجزَه عنها لَغا ولغط "
انظرْ إلى مثل ذلك فليس كلامُه هذا مما ذهبوا إليه في شيء
ويَنْبغي أن تكونَ مُوازنَتُهُم بينَ بعضِ الآي وبينَ ما قاله الناسُ في معناها كموازنِتِهم بين :
( ولكُم في القِصاصِ حياةٌ ) وبين : " قتلُ البعضِ إحياءٌ للجميع " خطأ منهم لأنّا لا نعلمُ لحديثِ التَّحريكِ والتسكين وحديثِ الفاصلةِ مذهباً في هذه الموازنة . ولا نعلمهم أرادوا غير ما يريدُه الناسُ إذا وازنوا بين كلام وكلام في الفصاحةِ والبلاغةِ ودقَّةِ النظم وزيادة الفائدة . ولولا أنَّ الشيطان قد استحوذ على كثيرٍ من الناس في هذا وأنهم بترك النظر وإهمالِ التدبُّرِ وضعفِ النِّية وقِصَر الهمَّة وقد طرَّقوا له حتى جَعَل يلقي في نفوسِهم كلَّ مُحال وكلَّ باطِل وجعلوا هُمْ يُعطون الذي يلقيهِ حظاً من قَبولهم ويبوِّؤنه مكاناً من قلوبهم لما بلغَ من قَدْر هذه الأقوالِ الفاسِدة أن تدخُل في تصنيفٍ ويعادَ ويُبدأ في تبيينٍ لوجهِ الفسادِ فيها وتعريف
ثم إنَّ هذه الشَّناعاتِ التي تقدَّم ذكرُها تُلزمُ أصحابَ الصَّرفة أيضاً . وذاكَ أنه لو لم يكنْ عَجْزُهم عن معارضةِ القرآن وعن أن يأتوا بمثلِه لأنه معجزٌ في نفسه لكن لأن أدخلَ عليهم العجْز عنه وصُرِفَتْ هِمَمهم وخواطِرُهم عن تأليفِ كلامٍ مثلِه . وكان حالُهم على الجملةِ حالَ من أُعْدِمَ العلمَ بشيء قد كان يعلَمُه وحِيلَ بينه ويبن أمرٍ قد كانَ يتَّسِعُ له لكانَ ينبغي أن لا يتعاظَمَهم ولا يكونَ ومنهم ما يدلُّ على إكبارِهم أمْرَه وتعجُّبِهم منه وعلى أنَه قد بَهَرهم وعَظُم كلَّ العِظَم عندَهم ولكانَ التعجُّبُ للذي دخلَ من العَجْزِ عليهم ولِما رأَوْه من تَغَيُّرِ حالهم ومن أنْ حِيل بينَهم ويبنَ شيءٍ قد كانَ عليهم سهلاً وأنْ سُدَّ دونَه بابٌ كانَ لهم مفتوحاً . أرأيتَ لو أن نبياً قال لقومِهِ : " إن آيتي أن أضعَ يدي على رأسي هذه الساعةَ وتُمْنَعونَ كلُّكم من أن تستطيعوا وضعَ أيديكم على رؤوسِكم " وكان الأمْرُ كما قال . كم يكون تعجبُ القوم أمن وضعِه يدَه على رأسهِ أم من عَجْزِهم أن يضعوا أيديَهم على رؤوسهم
ونعودُ إلى النسقِ فنقولُ : فإِذا بَطَلَ أن يكونَ الوصْفُ الذي أعجزَهم من القرآنِ في شيءٍ ممّا عدَدَناه لم يبقَ إلاّ أن يكونَ في الاستعارة . ولا يمكنُ أن تجعلَ الاستعارة الأصل في الإعجاز وأن يُقْصَرَ عليها لأن ذلك يؤدي إلى أنْ يكونَ الإِعجازُ في آيٍ معدودةٍ في مواضعَ من السورِ الطوالِ مخصوصةٍ . وإِذا امتنعَ ذلك فيها لم يبقَ إلا أن يكونَ في النظم والتأليفِ لأنه ليس من بَعدِ ما أبطلنا أن يكونَ فيه إلا النظمُ . وإذا ثبت أنه في النظمِ
والتأليف وكنَّا قد علمنا أنْ ليس النظمُ شيئاً غيرَ توخّي معاني النحو وأحكامِه فيما بينَ الكلمِ وأنَّا إنْ بقينا الدهرَ نُجهدُ أفكارَنا حتى نعلمَ للكلم المفردةِ سِلْكاً ينظمها وجامعاً يجمعُ شملَها ويؤلِّفها ويجعل بعضَها بسببٍ من بعضٍ غيرَ توخّي معاني النحو وأحكامه فيها طلبنا ما كلُّ محالٍ دونه
فقد بانَ وظهر أنّ المتعاطي القولَ في النظم والزاعمَ أنه يحاولُ بيانَ المزية فيه وهو لا يعرضُ فيما يعيدُه ويُبديه للقوانين والأصول التي قدَّمنا ذكرها ولا يسلك إليك المسالكَ التي نَهجناها في عمياءَ مِنْ أمره وفي غُرورٍ من نفسه وفي خداعٍ من الأماني والأضاليل . ذاك لأنه إذا كان لا يكونُ النظمُ شيئاً غيرَ توخّي معاني النحو وأحكامه فيما بينَ الكلم كان من أعجبِ العجب حينَ يزعمُ زاعمٌ أنه يطلبُ المزيَّةَ في النظم ثم لا يطلبُها في معاني النحو وأحكامِه التي النظم عبارةٌ عن توخّيها فيما بين الكلم
فإِنْ قيل : قولكَ : " إلاّ النظم " يقتضي إخراجَ ما في القرآنِ من الاستعارة وضروبِ المجاز من جملةِ ما هوَ به معجِزٌ وذلك ما لا مساغَ له . قيل : ليس الأمرُ كما ظننتَ بل ذلك يقتضي دخولَ الاستعارة ونظائرِها فيما هو به معجِزٌ . وذلك لأن هذه المعاني التي هيَ الاستعارةُ والكنايةُ والتمثيلُ وسائرُ ضروبِ المجاز من بعدها من مقتضيات النظمِ . وعنها يَحْدُث وبها يكون . لأنه لا يتصوَّر أن يدخلَ شيءٌ منها في الكلم وهي أفرادٌ لم يُتوخَّ فيما بينها حكمٌ من أحكام النحو فلا يتصوَّر أن يكونَ هاهنا فعلٌ أو اسمٌ قد دخلتْه الاستعارةُ من دونِ أن يكونَ قد ألّف مع غيره . أفلا ترى أنه إنْ قدَّر في اشتعل من قولهِ تعالى : ( واشْتَعلَ الرأسُ شيباً ) أنْ لا يكونَ الرأسُ فاعلاً له ويكونَ " شيباً " منصوباً عنه على التمييز لم يتصوَّر أن يكونَ مستعاراً . وهكذا السبيلُ في نظائر الاستعارة فاعرفْ ذلك
واعلمْ أن السببَ في إنْ لم يقعِ النظرُ منهم موقَعَه أنهم حين قالوا : نطلبُ المزية ظنوا أن موضعَها اللفظ بناءً على أنَّ النظمَ نظمُ الألفاظِ وأنه يلحقها دونَ المعاني . وحِينَ ظَنُّوا أنَّ موضِعَها ذلك واعتقدوه وقفوا على اللفظ وجعلوا لا يرمون بأوهامِهم إلى شيءٍ سواه . إلاّ أنهم على ذاك لم يستطيعوا أن ينطِقوا في تصحيح هذا الذي ظنوه بحرفٍ بل لم يتكلموا بشيء إلاّ كان ذلك نَقْضاً وإبطالاً لأن يكونَ اللفظُ من حيثُ هو لفظٌ موضعاً للمزيَّة
وإلاّ رأيتَهم قدِ اعترفوا من حيثُ لم يدروا بأنْ ليسَ للمزيَّة التي طلبوها موضعٌ ومكانٌ تكونُ فيه إلا معاني النحو وأحكامه . وذلك أنهم قالوا : إنَ الفصاحةَ لا تظهر في أفرادِ الكلماتِ وإنما تظهرُ بالضمِّ على طريقة مخصوصةٍ . فقولُهم : " بالنَّظم " لا يصحُّ أن يرادَ به النطقُ باللفظة بعدَ اللفظة من غير اتصالٍ يكونُ بين معنييهما لأنه لو جازَ أن يكونَ لمجرَّد ضَمِّ اللفظ إلى اللفظ تأثيرٌ في الفصاحةِ لكانَ يَنْبغي إذا قيلَ : " ضحِكَ خَرَجَ " أنْ يحدثَ من ضَمِّ " خرج " إلى " ضحك " فصاحةٌ . وإِذا بطلَ ذلك لم يبقَ إلاّ أن يكونَ المعنى في ضمِّ الكلمةِ إلى الكلمةِ توخّي معنًى من معاني النحو فيما بينهما . وقولُهم : على طريقةٍ مخصوصةٍ يوجِبُ ذلك أيضاً وذلك أنه لا يكونُ للطريقةِ - إذا أنتَ أردتَ مجردَ اللفظ - معنًى وهذا سبيلُ كلِ ما قالوه إِذا أنتَ تأمَّلْتَه تراهُم في الجميعِ قد دفعوا إلى جعلِ المزيّة في معاني النحو وأحكامِه من حيثُ لم يشعروا ذلك لأنه أمرٌ ضروريٌّ لا يمكن الخروج منه
ومما تجدُهم يعتمدونه ويرجِعُون إليه قولُهم : إن المعاني لا تتزايدُ وإنَّما تتزايدُ الألفاظُ . وهذا كلامٌ إذا تأملتَه لم تجدْ له معنًى يصحُّ عليه غيرَ أنْ تجعلَ تزايُدَ الألفاظِ عبارةً عن المزايا التي تحدثُ مِنْ توخِّي معاني النحوِ وأحكامِه فيما بينَ الكَلِم لأنَّ التزايدَ في الألفاظِ من حيثُ هي ألفاظٌ ونطقُ لسانٍ محالٌ
ثم إنَّا نعلمُ أنَّ المزيَّةَ المطلوبةَ في هذا الباب مزيَّةٌ فيما طريقُهُ الفكرُ والنظرُ من غيرِ شُبهة . ومحالٌ أن يكونَ اللفظُ له صفةٌ تُستنبَطُ بالفكر ويستعانُ عليها بالرويَّة . اللهمَّ إلا أن تريدَ تأليفَ النَّغم وليس ذلك ممّا نحنُ فيه بسبيلٍ . ومن هاهنا لم يَجُزْ إِذا عُدَّت الوجوه التي تظهرُ بها المزيةُ أن يُعَدَّ فيها الإِعرابُ وذلك أن العلم بالإعراب مشتركٌ بينَ العربِ كلِّهم وليس هو مما يُسْتَنْبَطُ بالفِكْر ويستعانُ عليه بالرويّة . فليسَ أحدُهُم بأنَّ إعرابَ الفاعِلِ يحتاجون فيه إلى حِدَّة ذهنٍ وقوّةِ خاطرِ إنما الذي تقعُ الحاجةُ فيه إلى ذلك العلمِ بما يوجِبُ الفاعليةَ للشيءِ إذا كان إيجابُها من طريقِ المجازِ كقولهِ تعالى : ( فما رَبِحَتْ تِجارتُهُم ) وكقولِ الفرزدق
( سَقَتْها خروقٌ في المسامعِ ... )
وأشباهُ ذلك مما يُجْعل الشيءُ فيه فاعلاً على تأويلٍ يَدقُّ ومن طريقٍ تلطُف . وليس يكونُ هذا علماً بالإِعراب ولكن بالوصفِ الموجِبِ للإِعراب . ومن ثمَّ لا يجوزُ لنا أن نعتدَ في شأنِنا هذا بأن يكونَ المتكلِّمُ قد استعمل من اللغتين في الشيء ما يقالُ إنه أفصحُهما وبأن يكون قد تحفَّظ مما تخطىءُ فيه العامَّة لا بأن يكون قد استعملَ الغريبَ لأن العلمَ بجميع ذلك لا يعدو أن يكون علماً باللغة بأنفَسِ الكَلِم المفردةِ وبما طريقهُ الحفظُ دونَ ما يستعانُ عليه بالنظر ويوصَلُ إليه بإِعمالِ الفكر . ولئن كانتِ العامَّةُ وأشباهُ العامةِ لا يكادون يعرفون الفصاحةَ غيرَ ذلك فإِنَّ من ضعفِ النَّحيزَة إخطارَ مثلهِ في الفكر وإجراءه في الذِّكر . وأنت تزعمُ أنّك ناظرٌ في دلائلِ الإِعجاز أتَرى أنّ العربَ تُحُدُّوا أن يختاروا الفتحَ في الميمِ من " الشَّمَع " والهاءِ منَ " النهْر " على الإِسكان . وأن يتحفظوا من تخليطِ العامَّة في مثل " هذا يَسْوى ألفاً " أو إلى أن يأتوا بالغريبِ الوحشيِّ في الكلام معارضون به القرآن كيف وأنتَ تقرأ السورةَ من السورِ الطوالِ فلا تجدُ فيها منَ الغريبِ شيئاً وتأمَّلْ ما جمعه العلماءُ في غريبِ القرآن فترى الغَريبَ منه إلا في القليلِ إنما كان غريباً من أجلِ استعارةٍ هي فيهِ كمثلِ : ( وأُشْرِبُوا في قُلُوبِهِمُ العِجْلَ ) ومِثْلِ : ( خَلَصُوا نَجِياًّ ) ومثل : ( فاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ ) دون أن تكون اللفظةُ غريبةً في نفسها . إنما ترى ذلك في كلماتٍ معدودةٍ كمثلِ : ( عَجِّلْ لَنا قِطَّنا ) و ( ذاتِ أَلْواحٍ ودُسُرٍ ) و ( جَعَلَ ربُّكِ تَحْتكِ سَرِيّاً )
ثم إنه لو كان أكثرُ ألفاظِ القرآن غَريباً لكان مُحالاً أن يدخلَ في الإِعجازِ وأن يصحَّ التحدِّي به . ذاك لأنه لا يَخْلو إذا وقعَ التحدِّي به من أن يُتَحدَّى مَنْ له عِلْمٌ بأمثالِه منَ الغريبِ أو مَنْ لا عِلْمَ له بذلك . فلو تُحدِّيَ به مَن يعلمُ أمثالَه لم يتعذَّر عليه أن يعارِضَه بمثله . ألا تَرى أنه لا يتعذَّرُ عليك إذا أنتَ عرفتَ ما جاء منَ الغريب في معنى - الطويل - أَنْ تُعارِضَ من يقولُ " الشَّوقب " بأن تَقولَ أنت : " الشَّوذب " . وإِذا قال : " الأمق " أن تقول : " الأشقّ " وعلى هذا السبيل . ولو تُحدِّي به من لا عِلْمَ له بأمثالِ ما فيه من الغريبِ كان ذلك بمنزلةِ أن يتحدّى العربَ إلى أن يتكلموا بلسانِ الترك
هذا وكيفَ بأن يدخلَ الغريبُ في بابِ الفضيلة وقد ثَبتَ عنهم أنهم كانوا يرون الفضيلة في تركِ استعماله وتجنُّبه . أفلا ترىَ إلى قولِ عمرَ رضي الله عنه في زهيرٍ : إنه كان لا يعاظِلُ بَيْنَ القولِ ولا يتتبَّعُ حُوشيَّ الكلام . فَقَرن تتبعَ الحُوشيِّ وهو الغريبُ من غير شُبهة إلى المعاظلة التي هيَ التعقيد
وقال الجاحظُ في كتاب البيان والتبيين : ورأيتُ الناسَ يتداولون رسالةَ يحيى بنِ يعمر عن لسان يزيدَ بن المهلَّبِ إلى الحجاج : " إنّا لقينا العدُوَّ فقتلنا طائفةً ولحقتْ طائفةٌ بعراعرِ الأودية وأهضامِ الغِيطان وبِتنا بعُرْعُرَة الجبلِ وباتَ العدُوُّ بحضيضِه " . فقال الحجاج : ما يزيدُ بأبي عُذْرِ هذا الكلام . فحُمِل إليه فقال : أينَ ولدتَ فقال : بالأهواز :
فقال : فأنّى لك هذه الفصاحةُ قال : أخذتُها عن أبي . قال : ورأيتُهم يُديرون في كتُبِهم أنَّ امرأةً خاصمتْ زوجَها إلى يحيى بنِ يعمُرَ فانتهرَها مراراً . فقال له يحيى : إن سألتُك ثمنَ شَكْرها وشَبْرِك أنشأتَ تُطِلُّها وتَضْهَلُها ثمَّ قال : وإن كانوا قَدْ رَوَوا هذا الكلامَ لكي يدلَّ على فصاحةٍ وبلاغة فقد باعدَه الله من صفةِ البلاغة والفَصاحة
واعلمْ أنك كلما نظرتَ وجدتَ سبَبَ الفسادِ واحداً وهو ظنُّهم الذي ظنُّوه في اللفظِ وجعلُهم الأوصافَ التي تَجري عليه كلَّها أوصافاً له في نفسِه ومن حيثُ هو لفظٌ . وتركُهم أن يميِّزوا بينَ ما كان وصفاً له في نفسِه ويبن ما كانوا قد أكسبوه إياه من أجلِ أمْرٍ عَرَضَ في معناه . ولما كان هذا دأبَهم ثم رأوا الناسَ وأظهرُ شيء عندَهُم في معنى الفصاحة : تقويمُ الإِعرابِ والتحفُّظُ منَ اللحن لم يَشكّوا أنه ينبغي أن يُعتدّ به في جملةِ المزايا التي يفاضل بها بينَ كلامٍ وكلامٍ في الفصاحة . وذهبَ عنهم أنْ ليس هو من الفصاحةِ التي يعنينا أمرُها في شيء . وإنَّ كلامنا في فصاحةٍ تجبُ للفظِ لا من أجل شيءٍ يدخل في النطق ولكن من أجل لطائفَ تُدرك بالفهم . وإنَّا نعتبرُ في شأنِنا هذا فضيلةً تجبُ لأحدِ الكلامين على الآخرِ من بعد أن يكونا قَد برِئا من اللَّحن وسَلِما في ألفاظِهما من الخطأ . ومن العجَبِ أنَّا إذا نظرنا في الإِعراب وجدنا التفاضلَ فيه محالاً لأنه لا يتصوَّر أن يكونَ للرفعِ والنصبِ في كلام مزيةٌ عليهما في كلامٍ آخر وإنما الذي يتصوَّر أن يكونَ هاهنا كلامان قد وقعَ في إعرابهما خللٌ ثم كان أحدُهما أكثرَ صواباً من الآخر . وكلامان قد استمر أحدُهما على الصَّوابِ ولم يستمرَّ الآخرُ . ولا يكونُ هذا تفاضلاً في الإِعراب ولكن تركاً له في شيءٍ واستعمالاً له في آخر فاعرفْ ذلك
وجملةُ الأمر أنك لا ترى ظناً هو أنأى بصاحبِه عن أن يصحَّ له كلامٌ أو يستمرَّ له نظام أو تثبُتَ له قَدَمٌ أو ينطِقَ منه إِلا بالمُحال فَمٌ من ظنِّهم هذا الذي حامَ بهم حولَ اللفظ وجعلهم لا يعدونهولا يَرَوْن للمزية مكاناً دونه
واعلمْ أنه قد يَجْري في العبارة منا شيءٌ هو يعيدُ الشُّبهةَ جَذَعةً عليهم وهو أنَّه يقعُ
في كلامِنا أنَّ الفصاحةَ تكون في المعنى دونَ اللفظِ ونراها لا تدخُلُ في صفةِ المعنى البتة لأنا نرى الناسَ قاطبةً يقولون : هذا لفظٌ فصيحٌ وهذه ألفاظٌ فصيحة . ولا نرى عاقلاً يقولُ : هذا معنى فصيحٌ وهذه معانٍ فصاحٌ . ولو كانتِ الفصاحةُ تكونُ في المعنى لكانَ ينبغي أن يقال ذاك . كما أنه لما كان الحسن يكونُ فيه قيل : " هذا معنًى حسنٌ وهذه معانٍ حسنة " . وهذا شيء يأخذ من الغِرِّ مأخذاً
والجوابُ عنه أن يقال : إِن غرضَنا من قولنا : إِنَّ الفصاحةَ تكون في المعنى أنَّ المزيَّةَ التي من أجلِها استحقَّ اللفظُ الوصفَ بأنه فصيحٌ عائدةٌ في الحقيقة إِلى معناه . ولو قيل إِنها تكون فيه دونَ معناه لكان ينبغي إِذا قلنا في اللفظةِ إِنها فصيحةٌ أن تكونَ تلك الفصاحةُ واجبةً لها بكل حالٍ . ومعلومٌ أنَّ الأمْرَ بخلافِ ذلك فإِنا نرى اللفظةَ تكون في غايةِ الفصاحةِ في موضعٍ ونراها بعينها فيما لا يُحصى من المواضِع وليس فيها منَ الفصاحة قليلٌ ولا كثيرٌ . وإِنما كان كذلك لأنَّ المزيةَ التي مِنْ أجلها نَصِفُ اللفظَ في شأننا هذا بأنه فصيحٌ مزيةٌ تحدثُ مِنْ بَعْدِ أن لا تكونَ وتظهرُ في الكلم من بعد أن يدخُلَها النظم . وهذا شيءٌ إِن أنتَ طلبتَه فيها وقد جئتَ بها أفراداً لم تَرُمْ فيها نظماً ولم تحدثْ لها تأليفاً طلبتَ مُحالاً
وإِذا كان كذلك وجبَ أن يُعلَمَ قطعاً وضرورةً أن تلك المزيةَ في المعنى دونَ اللفظ . وعبارةُ أخرى في هذا بعينه وهي أن يقالَ : قد علمنا علماً لا تعترضُ معه شُبهةٌ أن الفصاحةَ فيما نحن فيه عبارةٌ عن مزيَّة هي بالمتكلِّم دونَ واضعِ اللغة . وإِذا كان كذلك فينبغي لنا أن ننظرَ إِلى المتكلم هل يستطيعُ أن يزيدَ من عند نفسهِ في اللفظِ شيئاً ليس هو له في اللغة حتى يجعلَ ذلك من صنيعه مزيةً يعبر عنها بالفصاحة وإِذا نظرنا وجدْناه لا يستطيع أن يصنعَ باللفظ شيئاً أصلاً ولا أن يُحدثَ فيه وصفاً . كيف وهو إِن فعلَ ذلك أفسدَ عل نفسه وابطلَ أن يكونَ متكلماً لأنه لا يكون متكلما حتى يستعملَ أوضاعَ لغةٍ على ما وُضعتْ هي عليه . وإِذا ثبت من حالِه أنه لا يستطيعُ أن يصنعَ بالألفاظِ شيئاً ليس هو لها في اللغة . وكنا قد اجتمعنا على أن الفصاحةَ فيما نحن فيه عبارةٌ عن مزيَّة هي بالمتكلِّم البتةَ وجبَ أن نعلمَ قَطعاً وضَرورةً أنَّهم وإِن كانوا قد جعلوا الفصاحةَ في ظاهرِ الاستعمالِ من صفة الَّلفظ فإِنَهم لم يجعلوها وصفاً له في نفسه ومن حيث هو صدى صوتٍ ونطقُ لسانٍ ولكنهم جعلوها عبارةً عن مزية أفادها المتكلمُ ولما لم تَزِد إِفادتُه في اللفظ شيئاً لم يبقَ إِلا أن تكون عبارةً
عن مزية في المعنى
وجملة الأمْرِ أنَّا لا نوجِبُ الفصاحةَ للفظةٍ مقطوعةٍ مرفوعة من الكلامِ الذي هي فيه ولكنَّا نوجبُها لها موصولةً بغيرها ومعلَّقاً معناها بمعنى ما يليها . فإِذا قلنا في لفظةِ " اشتعل " من قولهِ تعالى : ( واشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ) : إِنها في أعلى المرتبة من الفصاحةِ لم نوجِبْ تلك الفصاحةَ لها وحدها ولكن موصولاً بها الرأسُ معرَّفاً بالألف واللام ومروناً إِليها الشَّيْبُ منكَّراً منصوباً
هذا وإِنما يقعُ ذلك في الوَهْم لمن يَقَعُ له أعني أن تُوجبَ الفصاحة للفظة وحدَها فيما كان استعارةً . فأما ما خلا منَ الاستعارة من الكلام الفصيح البليغِ فلا يعرِضُ توهُّمُ ذلك فيه لعاقلٍ أصلاً . أفلا تَرى أنه لا يقعُ في نفسِ مَن يعقِل أدنى شيءٍ إِذا هو نظرَ إِلى قولهِ عزَّ وجلَّ : ( يَحسَبوْنَ كلَّ صَيحةٍ عَلَيْهم هُمُ العَدوُّ فَاحْذَرهُمْ ) . وإلى إِكبارِ الناس شأنَ هذه الآية في الفصاحة أن يضعَ يدَه على كلمةٍ كلمةٍ منها فيقولُ : إِنها فصيحة كيف وسببُ الفصاحة فيها أمورٌ لا يشكُّ عاقلٌ في أنها معنوية :
أوَّلُها : أن كانت " على " فيها متعلقةً بمحذوف في موضع المفعولِ الثاني . والثاني : أن كانت الجملةُ التي هي " هم العدوُّ " بعدها عاريةً من حرف عطف . والثالث : التعريفُ في العدوّ وأنْ لم يقل : هم عدوٌّ . ولو أنك علَّقتَ " على " بظاهر وأدخلتَ على الجملة التي هيَ " هم العدوُّ " حرفَ عطف وأسقطتَ الألف واللام من العدوّ فقلت : يحسَبون كلَّ صيحة واقعةً عليهم وهم عدو لرأيتَ الفصاحةَ قد ذهبتْ عنها بأسرها . ولو أنك أخطرتَ ببالك أن يكونَ " عليهم " متعلِّقاً بنفس الصَّيحة ويكون حالهُ معها كحاله إِذا قلتَ : صِحْتُ عليه لأخرجتَه عن أن يكونَ كلاماً فضلاً عن أن يكونَ فصيحاً . وهذا هو الفَيْصلُ لمن عَقَل
ومن العجيبِ في هذا ما رُويَ عن أمير المؤمنين عليٍّ رضوانُ الله عليه أنه قال : ما سمعتُ كلمة عربيةً منَ العرب إِلا وسمعتُها من رسولِ الله . وسمعتُه يقول : " مات حَتْفَ
أنفِهِ " وما سمعتُها من عربيٍّ قبله . لا شُبهةَ في أن وصفَ اللفظ بالعربي في مثلِ هذا يكون في معنى الوصف بأنه فصيح . وإِذا كان الأمرُ كذلك فانظر هل يقعُ في وَهْمِ متوهِّمٍ أن يكونَ رضي الله عنه قد جعلَها عربية من أجلِ ألفاظِها وإِذا نظرتَ لم تشكَّ في ذلك
واعلمْ أنك تجدُ هؤلاءِ الذين يشكُّون فيما قلناه تجري على ألسنتهم ألفاظٌ وعباراتٌ لا يصحُّ لها معنى سوى توخِّي معاني النحو وأحكامِه فيما بين معاني الكَلِم . ثم تراهم لا يعلمون ذلك . فمن ذلك ما يقولُه الناسُ قاطبة من أن العاقلَ يرتِّب في نفسه ما يريدُ أن يتكلَّم به . وإِذا رجعنا إِلى أنفسنا لم نجد لذلك معنًى سوى أنه يقصِدُ إِلى قولِكَ ضربَ فيجعلُه خبراً عن زيد ويجعلُ الضربَ الذي أخبر بوقوعهِ منه واقعاً عل عمرٍو ويجعلُ يومَ الجمعة زمانه الذي وقعَ فيه ويجعلُ التأديبَ غرضَه الذي فعل الضربَ من أجله فيقولُ : ضربَ زيد عمراً يوم الجمعة تأديباً له . وهذا كما ترى هو توخِّي معاني النحو فيما بين معاني هذه الكلم . ولو أنك فرضتَ أن لا تتوخَّى في " ضَرَبَ " : أن تجعله خبراً عن زيدٍ وفي عمرٍو أن تجعَله مفعولاً به لضرب وفي يومِ الجمعة أن تجعَله زماناً لهذا الضرب وفي التأديب أن تجعلَه غرضَ زيدٍ من فعل الضرب ما تُصوِّر في عقلٍ ولا وقع في وَهْم أن تكونَ مرتِّباً لهذه الكلم . وإِذ قد عرفتَ ذلك فهو العبرةُ في الكلام كلِّه فمن ظنَّ ظناّ يؤدِّي إِلى خلافِه ظنَّ ما يخرج به عن المعقول
ومن ذلك إِثباتُهم التعلقّ والاتصالَ فيما بينَ الكلم وصواحِبها تارة ونفيهم لهما أخرى . ومعلومٌ علمَ الضرورة أن لن يتصوَّرَ أن يكونَ للفظةٍ تعلُّقٌ بلفظةٍ أخرى من غيرِ أن تعتبرَ حالَ معنى هذه مع معنى تلك . ويراعى هناك أمرٌ يصلُ إِحداهما بأخرى كمراعاةِ " نَبْكِ " جواباً للأَمْرِ في قوله : قفا نبك : وكيفَ بالشكِّ في ذلك . ولو كانت الألفاظُ يتعلقّ بعضُها ببعض من حيثُ هي ألفاظٌ ومع اطِّراح النظر في معانيها لأدَّى ذلك إلى أن يكونَ الناس حين ضَحكوا مما يصنعه المُجَّانُ من قرّاءِ أنصافِ الكتب ضَحِكوا عن جهالةٍ وأن يكونَ أبو تمام قد أخطأ حين قال :
( عَذَلاً شَبِيْهاً بالجُنونِ كأَنَّما ... قَرأَتْ بِهِ الوَرْهاءُ شَطْرَ كتابِ )
لأنَّهم لم يضحَكُوا إِلاَّ من عَدَم التعلُّق ولم يجعلْه أبو تمام جُنوناً إِلاَّ لذلك فانظرْ إِلى ما يلزَمُ هؤلاءِ القوم من طرائِفِ الأمورِ
فصل وهذا فَنٌّ من الاستدلال لطيف على بُطلان أن تكون الفصاحةُ صفةً لِلَّفْظِ من حيثُ هو لفظ
لا تخلو الفصاحةُ من أن تكونَ صفةً في اللفظ محسوسةً تُدرَك بالسَّمْع أو تكونَ صفةً فيه معقولةً تُعرف بالقلب . فمحالٌ أن تكونَ صفةُ اللفظ محسوسةً لأنها لو كانت كذلك لكان ينبغي أن يستويَ السامعون للَّفظ الفصيح في العلم بكونه فصيحاً . وإِذا بطَلَ أنْ تكونَ محسوسةً وجبَ الحكمُ ضرورة بأنها صفةٌ معقولة . وإِذا وجَبَ الحكمُ بكونِها صفةً معقولةً فإِنا لا نعرفُ للَّفظِ صفةً يكون طريقُ معرفتها العقلَ دونَ الحسِّ إِلا دلالته على معناهُ . وإِذا كان كذلك لَزِم منه العلم بأنَّ وصفَنا اللفظَ بالفصاحةِ وصفٌ له من جِهَة معناه لا من جهةِ نفسه . وهذا ما لا يبقى لعاقلٍ معه عُذْرٌ في الشكِّ واللهُ الموفِّقُ للصَّوابِ
فصل في أن الفصاحة في الكلمة لا في حروفها
وبيانٌ آخرُ وهو أن القارىء إِذا قرأ قولَه تعالى : ( واشْتَعَلَ الرَّأَسُ شَيْباً ) فإِنه لا يَجِدُ الفصاحةَ التي يجدُها إِلاَّ من بعدِ أن ينتهيَ الكلام إِلى آخرهِ . فلو كانت الفصاحةُ صفةً للفظ " اشتعل " لكان ينبغي أن يُحسَّها القارىءُ فهي حالَ نطقه به فمحالٌ أن تكونَ للشيء صفةً ثم لا يصحُّ العلم بتلك الصفةِ إِلاَّ من بعد عَدَمِه . ومَنْ ذا رأى صفة يَعْرى موصوفُها عنها في حالِ وجودهِ حتى إِذا عُدِمَ صارت موجودةً فيه وهل سَمِع السامعون في قديم الدهر وحديثه بصفةٍ شرطُ حصولها لموصوفها أنْ يُعْدَمَ الموصوفُ فإِن قالوا إِن الفصاحة التي ادَّعيناها للفظ " اشتعل " تكونُ فيه في حال نُطقنا به إِلا أنَّا نعلم في تلك الحال أنها فيه فإِذا بلغنا آخرَ الكلام علمنا حينئذٍ أنها كانت فيه حينَ نَطَقْنا . قيل : هذا فنٌّ آخرُ من العَجَب وهو أن تكونَ هاهُنا صفةٌ موجودةٌ في شيءٍ ثم لا يكونُ في الإِمكان ولا يسعُ في الجواز أن نَعْلَمَ وجودَ تلك الصفة في ذلك الشيء إِلا بعد أن يعدمَ . ويكونُ العلمُ بها وبكونها فيه محجوباً عَنّا حتى يَعدمَ فإِذا عُدِمَ علمنا أنها كانت فيه حينَ كانَثم إِنه لا شُبهةَ في أن هذه الفصاحةَ التي يدَّعونها للفظ هي مدعاةٌ لمجموعِ الكلمة دون آحاد حروفها إِذ ليس يبلغُ بهم تهافتُ الرأي إِلى أن يدَّعوا لِكلِّ واحدٍ من حروفِ " اشتعل " فصاحةً فيجعلوا الشينَ على حِدَتِه فصيحاً وكذلك التاء والعين واللام . وإِذا كانتِ الفصاحةُ مُدّعاةً لمجموعِ الكلمة لم يُتصوَّر حصولُها لها إِلاّ من بعد أن تعدم كلها وينقضي أمرُ النطقِ بها . ذلك لأنه لا يُتصوَّر أن تدخل الحروفُ بجملتها في النطق دفعةً واحدة حتى تجعلَ الفصاحةَ موجودةً فيها في حالِ وجودها وما بعد هذا إِلاّ أن نسأل اللهَ تعالى العصمةَ
والتوفيق . فقد بلغ الأمرُ في الشَّناعة إِلى حَدٍّ إِذا انتبه العاقلُ لَفَّ رأسه حياءً من العقلِ حين يراه قد قال قولاً هذا مؤداه وسلك مَسْلكاً إِلى هذا مَفضاه . وما مَثَلُ مَنْ يزعمُ أن الفصاحةَ صفةُ اللفظ من حيثُ هو لفظٌ ونطقُ لسانٍ ثم يزعمُ أنه يدَّعيها لمجموع حروفِه دونَ آحادها إِلاّ مَثَلُ من يزعمُ أن هاهنا غَزْلاً إِذا نُسجَ منه ثوبٌ كان أحمرَ وإِذا فُرِّق ونُظر إليه خيطاً خيطاً لم تكنْ فيه حمرةٌ أصلاً
ومن طريفِ أمرِهم أنك ترى كافَّتَهم لا يُنكرون أن اللفظ المستعارَ إِذا كان فصيحا كانت فصاحته تلك من أجل استعارتِه ومن أجل لطفٍ وغرابةٍ كانا فيها . وتراهُم مع ذلك لا يشكّون في أن الاستعارة لا تُحدِثُ في حروفِ اللفظ صفةً ولا تُغيِّر أجراسَها عما تكونُ عليه إِذا لم يكن مستعاراً وكان متروكاً على حقيقته . وأنّ التأثيرَ من الاستعارة إِنما يكون في المعنى . كيفَ وَهُم يعتقدون أن اللفظَ إِذا استعيرَ لشيء نُقِل عن معناه الذي وُضع له بالكلية . وإِذا كان الأمرُ كذلك فلولا إِهمالُهم أنفسَهم وتركهم النظرَ لقد كان يكونُ في هذا ما يوقظُهم من غَفْلَتِهم ويكشفُ الغطاءَ عن أعينهم
فصل علاقة الفكر بمعاني النحو
ومما ينبغي أن يعلمَه الإِنسانُ ويجعلَه على ذكرِ أنه لا يتصوَّر أن يتعلَّق الفكرُ بمعاني الكلم أفراداً ومجرَّدة من معاني النحو فلا يقوم في وهمٍ ولا يصحُّ في عَقْل أن يتفكرَ متفكِّر في معنى فعلٍ من غيرِ أن يريدَ إِعمالَه في اسمٍ . ولا أن يتفكَّر في معنى اسم من غير أن يريدَ إِعمال فعلٍ فيه وجعله فاعلاً له أو مفعولاً . أو يريدَ منه حكماً سوى ذلك من الأحكام مثل أن يريدَ جعلَه مبتدأ أو خبراً أو صفة أو حالاً أو ما شاكل ذلك . وإِن أردتَ أن ترى ذلك عِياناً فاعمِد إِلى أيِّ كلام شئتَ وأزِلْ أجزاءه عن مواضعها وضَعْها وضعاً يمتنعُ معه دخولُ شيءٍ من معاني النحو فيها فقل في :( قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِ ... )
" من نبك قفا حبيب ذكرى منزل " ثم انظرْ هل يتعلَّق منك فكرٌ بمعنى كلمة منها
واعلمْ أني لستُ أقول إِن الفِكْر لا يتعلَّق بمعاني الكلم المفردة أصلاً ولكني أقولُ إِنه لا يتعلَّق بها مجرَّدةً من معاني النحو ومنطوقاً بها على وجهٍ لا يتأتَّى معه تقديرُ معاني النحو وتوخّيها فيها كالذي أريتُك . وإِلا فإِنّك إِذا فكّرتَ في الفعلين أو الاسمين تريدُ أن تخبرَ بأَحَدِهِما عن الشيء أيُّهما أَولى أن تُخبرَ به عنه وأشبهُ بغرضك مثل أن تنظرَ أيُّهما أمْدَحُ وأذمُّ أو فكّرتَ في الشيئين تريدُ أن تشبِّه الشيءَ بأحدِهما أيّهما أشبهُ به كنتَ قد فكرتَ في معاني أنفُسِ الكلم . إِلاّ أنَّ فكرك ذلك لم يكن إِلاّ من بعد أن توخَّيتَ فيها من معاني النحو وهو أن أردتَ جعلَ الاسم الذي فكرتَ فيه خبراً عن شيءٍ أردتَ فيه مدحاً أو ذماً أو تشبيهاً أو غيرَ ذلك من الأغراضِ . ولم تَجىءْ إِلى فعل أو اسم فكَّرْتَ فيه فرداً ومن غير أن كان لك قَصْدٌ أنْ تجعلَه خبراً أو غيرَ خبرٍ فاعرِفْ ذلك . وإِن أردتَ مثالاً فخذ بيتَ بشار - الطويل - :
( كأن مُثارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُؤوسنا ... وأَسْيافَنا لَيْلٌ تَهاوى كَواكِبُهْ )
وانظرْ هل يتصورُ أن يكون بشارٌ قد أخطرَ معاني هذا الكلم بباله أفراداً عاريةً من معاني النحو التي تراها فيها وأن يكونَ قد وقَع " كأنّ " : في نفسه من غيرِ أن يكونَ قَصَدَ إِيقاعَ التشبيه منه على شيء وأنْ يكونَ فكَّر في " مُثار النقع " من غير أن يكونَ أراد إِضافةَ الأول إِلى الثاني وفكَّر في " فوق رؤوسنا " من غير أن يكون قد أرادَ أن يضيفَ " فوق " إِلى الرؤوس وفي الأسيافِ من دون أن يكونَ أرادَ عطفَها بالواو على " مثار " وفي الواو من دونِ أن يكونَ أرادَ العطف بها وأن يكون ذلك فكَّر في " اللَّيل " مِنْ دونِ أن يكونَ أرادَ أن يجعلَه خبراً لكأن وفي " تَهَاوَى كواكِبُه " من دون أن يكون أرادَ أن يجعلَ تهاوى فعلاً للكواكب ثم يجعل الجملةَ صفةً لليل ليتمَّ الذي أراد من التشبيه أم لم تخْطُرْ هذه الأشياءُ ببالهِ إِلاّ مُراداً فيه هذه الأحكامُ والمعاني التي تراها فيها
وليت شعري كي يتصورُ وقوعُ قَصْدٍ منك إِلى معنى كلمةٍ من دُونِ أن تريدَ تعليقَها
بمعنى كلمة أخرى ومعنى القصد إِلى معاني الكلم أن تُعْلِمَ السامعَ بها شيئاً لا يعلمه ومعلوم أنك أيها المتكلمُ لستَ تقصدُ أن تُعلمَ السامعَ معاني الكلم المفردةِ التي تكلمه بها فلا تقولُ : خرجَ زيدٌ لتعلِمَه معنى خرجَ في اللغة ومعنى زيدٍ كيفَ ومحالٌ أن تكلمَه بألفاظٍ لا يعرفُ هو معانيها كما تعرف ولهذا لم يكن الفعلُ وحدَه من دون الاسم ولا الاسمُ وحدَه من دون اسمٍ آخرَ أو فعلٍ كلاماً . وكنتَ لو قلتَ : " خرج " ولم تأتِ باسمٍ ولا قدَّرْتَ فيه ضميرَ الشيء أو قلتَ : زيد ولم تأتِ بفعل ولا اسم آخر ولم تُضْمِرْه في نفسك كان ذلك وصوتاً تُصوِّتُه سَواء فاعرفْه
واعلمْ أنَّ مثَلَ واضع الكلام مَثَلُ من يأخذ قطعاً من الذهب أو الفضة فيذيبُ بعضَها في بعض حتى تصيرَ قطعةً واحدة . وذلك أنك إِذا قلتَ : ضرب زيدٌ عمراً يومَ الجمعة ضرباً شديداً تأديباً له فإِنك تحصلُ من مجموعِ هذه الكلمِ كلِّها على مفهومٍ هو معنى واحدٌ لا عِدَّةُ معانٍ كما يتوهَّمه الناسُ . وذلك لأنك لم تأتِ بهذه الكَلِمِ لتفيدَه أنفُسَ معانيها وإِنما جئتَ بها لتفيدَه وجوهُ التعلُّق التي بينَ الفعل الذي هو " ضَربَ " وبينَ ما عملَ فيه والأحكامُ التي هي محصولُ التعلُّق . وإِذا كان الأمرُ كذلك فينبغي لنا أن ننظرَ في المفعولية من " عمرٍو " وكونِ يوم الجمعة زماناً للضرب وكونِ الضرب ضرباً شديداً وكونِ التأديب علَّةً للضرب . أيتصوَّر فيها أن تُفردَ عن المعنى الأول الذي هو أصلُ الفائدةٍ وهو إِسنادُ " ضَرَب " إِلى زيد وإِثباتُ الضَّرْبِ به له حتى يعقلَ كونُ عمرٍو مفعولاً به وكونُ يوم الجمعة مفعولاً فيه وكونُ ضرباً شديداً مصدراً وكونُ التأديب مفعولاً له من غيرِ أن يخطُر ببالك كونُ زيد فاعلاً للضربِ وإِذا نظرنا وجدنا ذلك لا يتصوَّر لأن عمرًا مفعولٌ لضرب وَقَع من زيد عليه ويومَ الجمعة زمانٌ لضربَ وقع من زيد وضرباً شديداً بيانٌ لذلك الضرب كيف هو وما صفته والأديبُ علة له وبيان أنه كان الغرض منه . وإِذا كان ذلك كذلك بانَ منه وثَبَتَ أن المفهومَ من مجموع الكلم معنًى واحدٌ لا عدةُ معانٍ وهو إِثباتُك زيداً فاعلاً ضرْباً لعمرْو في وقتِ كذا وعلى صفة كذا ولغرض كذا . ولهذا المعنى تقول : إِنه كلام واحدٌ
وإِذ قد عرفتَ هذا فهو العبرةُ أبداً فبيتُ بشار إِذا تأملتَه وجدَته كالحَلْقةِ المُفرغة التي لا تقبل التقسيمَ ورأيتَه قد صنعَ في الكلم التي فيه ما يصنعُه الصانعُ حين يأخذ كِسَراً من الذهب فيذيبها ثم يصبُّها في قالبٍ ويخرجُها لك سِواراً أو خَلخالاً . وإنْ أنت حاولتَ قطعَ
بعض ألفاظ البيت عن بعض كنتَ كمن يكسرُ الحَلْقةَ ويفصِمُ السِّوار . وذلك أنه لم يردْ أن يشبِّه النقعَ بالليل على حدةٍ والأسيافَ بالكواكب على حدة . ولكنه أراد أن يشبِّه النقعَ والأسياف تجولُ فيه بالليل في حالِ ما تنكدر الكواكبُ وتتهاوى فيه
فالمفهومُ من الجميع مفهومٌ واحد والبيت من أوله إِلى آخره كلام واحد . فانظر الآن ما تقول في اتحادِ هذه الكلم التي هي أجزاءُ البيت أتقولُ : إِن ألفاظَها اتَّحدتْ فصارتْ لفظةً واحدة أم تقول : إِن معانيها اتَحدتْ فصارتْ ألفاظُ من أجل ذلك كأنَّها لفظةٌ واحدة فإِن كنتَ لا تشكُّ أنّ الاتحادَ الذي تراه هو في المعاني إِذْ كان من فسادِ العقل ومن الذهاب في الخَبل أن يتوهَّم متوهمٌ أن الألفاظَ يندمجُ بعضُها في بعض حتى تصيرَ لفظةً واحدة . فقد أراك ذلك - إِن لم تُكابرْ عقلك - أن النظمَ يكون في معاني الكلم دونَ ألفاظها وأن نظَمها هو توخّي معاني النحوِ فيها . وذلك أنه إِذا ثبتَ الاتحادُ وثبتَ أنه في المعاني فينبغي أن تنظرَ إِلى الذي به اتَّحدتِ المعاني في بيتِ بشار . وإِذا نظرنا لم نجدْها اتحدتْ إِلا بأنْ جَعَلَ مُثارَ النقع اسمَ كأنَّ وَجَعَلَ الظرفَ الذي هو " فوق رؤوسنا " معمولاً لمثارٍ ومعلّقاً به وأَشَرْكَ الأسيافَ في كأنَّ بعطفِه لها على مُثار ثم بأن قال : ليلٌ تهاوى كواكِبُه فأتَى بالليل نكرةً وجعل جملةَ قوله : تهاوى كواكِبُه له صفةً ثم جعل مجموعَ " ليل تهاوى كواكِبُه " خبراً لكأن . فانظر هل ترى شيئاً كان الاتحادُ به غيرَ ما عدَّدناه وهل تعرفُ له مُوجباً سِواه فلولا الإِخلادُ إِلى الهوينا وتركُ النظر وغطاءٌ ألقيَ على عيون أقوامٍ لكان ينبغي أن يكونَ في هذا وحدَه الكفايةُ وما فوق الكفاية . ونسأل الله تعالى التوفيقَ . واعلمْ أن الذي هو آفةُ هؤلاء الذي لَهَجوا بالأباطيلِ في أمر اللفظ أنَّهم قومٌ قد أسلموا أنفسَهم إلى التخيُّل وألقوا مقادَتَهم إِلى ا لأوهام حتى عدلتْ بهم عن الصَّوابِ كلَّ مَعدل ودخلتْ بهم من فحشِ الغَلَطِ في كلِّ مدخل وتعسَّفَتْ بهم في كلِّ مَجْهلِ وجعلتْهم يرتكبون في نُصرة رأيِهم الفاسِد القولَ بكلِّ مُحال ويقتحمون في كلِّ جَهالة . حتى إِنك لو قلتَ لهم : إِنه لا يتأتَّى للناظم نظمُه إِلا بالفكر والروية فإِذا جعلتم النظمَ في الألفاظِ
لزمكُم من ذلك أن تجعلوا فِكْر الإِنسان - إِذا هو فكَّر - في نظم الكلام فكراً في الألفاظ التي يريدُ أن ينطِقَ بها دون المعاني لم يبالوا أن يرتكبوا ذلك وأن يتعلقوا فيه بما في العادة ومَجْرى الجِبلَّة من أن الإِنسانَ يُخيَّل إِليه إِذا هو فكَّر أنه كان ينطِقُ في نفسه بالألفاظ التي يفكّر في معانيها حتى يرى أن يسمَعَها سماعَه لها حين يخرجها من فيهِ وحين يُجري بها اللسان . وهذا تجاهلٌ لأن سبيلَ ذلك سبيلُ إِنسانٍ يتخيّل دائماً في الشيء قد رآه وشاهدَه أنه كأنَّه يراه وينظر إِليه . وأنَّ مثاله نُصْبَ عينيه . فكما لا يوجب هذا أن يكون رائياً له وأن يكون الشيءُ موجوداً في نفسه كذلك لا يكونُ تخيلُه أنه كان ينطق بالألفاظِ موجباً أن يكون ناطقاً بها . وأن تكونَ موجودةً في نفسه حتى يجعلَ ذلك سبباً إِلى جعل الفكر فيها . ثم إِنَّا نعلمُ أنه ينطِقُ بالألفاظِ في نفسه وأنه يجدُها فيها على الحقيقة . فمن أينَ لنا أنه إِذا فكر كان الفكرُ منه فيها أم ماذا يَرومُ ليتَ شعري بذلك الفكر ومعلوم أن الفكر من الإِنسانِ يكونُ في أن يُخبِرَ عن شيءٍ بشيءٍ أو يصفَ شيئاً بشيءٍ أو يضيفَ شيئاً إلى شيء أو يُشرِكَ شيئاً في حكم شيء أو يخرجَ شيئاً من حكم قد سبق منه لشيء أو يجعلَ وجودَ شيء شرطاً في وجودِ شيء وعلى هذا السبيلُ . وهذا كلُّه فكرٌ في أمورٍ معلومة معقولةٍ زائدة على اللفظ
وإِذا كان هذا كذلك لم يخلُ هذا الذي يُجْعَل في الألفاظِ فكراً من أحدِ أمرين : إِمّا أن يُخرج هذه المعاني من أن يكونَ لواضعِ الكلامِ فيها فكرٌ ويجعلَ الفِكْرَ كلَّه في الألفاظِ . وإِما أن يجعلَ له فكراً في اللفظ مفرداً عن الفكرة في هذه المعاني فإِن ذهَب إِلى الأول لم يكلم وإِن ذهب إلى الثاني لَزِمه أن يجوِّزَ وقوعَ فكرٍ من الأعجمي الذي لا يعرِفُ معانيَ ألفاظِ العربية أصلاً في الألفاظِ وذلك مما لا يَخْفى مكانُ الشُّنْعة والفضيحة فيه
وشبيهٌ بهذا التوهُّم منهم أنك قد ترى أحدَهم يعتبر حالَ السامع فإِذا رأى المعاني لا تترتَّب في نفسِه إِلاّ بترتُّب الألفاظِ في سمعه ظنَّ عند ذلك أن المعاني تبعٌ للألفاظ وأن الترتُّب فيها مكتَسبٌ من الألفاظ ومن ترتُّبها في نطقِ المتكلم . وهذا ظنٌّ فاسد ممن يظنه فإِنَّ الاعتبار ينبغي أن يكون بحالِ الواضع للكلام والمؤلِّف له . والواجبُ أن ينظرَ إِلى حالِ المعاني معه لا مَعَ السامعِ . وإِذا نظرنا عَلِمنا ضرورةً أنه مُحَالٌ أن يكونَ الترتُّبُ فيها تَبَعاً لترتُّبِ الألفاظِ ومكتَسباً عنه لأن ذلك يقتضي أن تكونَ الألفاظُ سابقةً للمعاني وأن تقعَ في
نفس الإِنسان أولاً ثم تقعَ المعاني من بَعْدِها وتالية لها بالعكس مما يعلمُه كلُّ عاقل إِذا هو لم يأخذْ عن نفسه ولم يُضرب حجابٌ بينه وبينَ عقله . وليتَ شعري هل كانتِ الألفاظُ إِلاّ من أجل المعاني وهل هي إِلاّ خدمٌ لها ومصرَّفةٌ على حكمها أوَ ليست هي سماتٍ لها وأوضاعاً قد وضِعَتْ لتدلَّ عليها فكيفَ يُتصوَّر أن تسبِقَ المعاني وأن تتقدَّمَها في تصوُّر النفس إِن جازَ ذلك جاز أن تكون أسامي الأشياء قد وُضعتْ قبل أن عرفتْ الأشياء وقيلَ أن كانتْ . وما أدري ما أقولُ في شيءٍ يجرُّ الذاهبين إليه إِلى أشباهِ هذا من فنونِ المُحال ورديءِ الأَقْوال ! وهذا سؤالٌ لهم من جِنْسٍ آخرَ في النظم : قالوا : لو كان النظمُ يكون في معاني النحو لكان البدويُّ الذي لم يسمعْ بالنحوِ قطُّ ولم يعرفِ المبتدأَ والخبر وشيئاً ممّا يذكرونه لا يتأتَّى له نظمُ كلام . وإِنَّا لنراه يأتي في كلامِه بنظمٍ لا يُحسنه المتقدِّمُ في علمِ النحو . قيل : هذه شُبهةٌ من جنس ما عرضَ للذين عابوا المتكلمين فقالوا : إِنَّا نعلم أن الصحابةَ رضي اللهُ عنهم والعلماءَ في الصدر الأَول لم يكونوا يعرفون الجوهَرَ والعَرَضَ وصفةَ النفس وصفةَ المعنى وسائرَ العبارات التي وضعتموها . فإِنْ كان لا تَتِمُّ الدَّلالةُ على حدوثِ العالم والعلم بوحدانية الله إِلاّ بمعرفة هذه الأشياء التي ابتدأتُموها فينبغي لكم أنْ تدَّعوا أنكم قد علمتُم في ذلك ما لم يعلموهُ وأنَّ منزلَتُكم في العلم أعلى من منازلهم . وجوابُنا هو مثلُ جوابِ المتكلمين وهو أنَّ الاعتبارَ بمعرفة مدلولِ العبارات لا بمعرفة العبارات فإِذا عَرَفَ البدويُّ الفَرْقَ بين أنْ يقولَ : جاءني زيدٌ راكباً وبين قولهِ : جاءني زيدٌ الراكبُ لم يضِرْه أن لا يعرفَ أنه إِذا قال : " راكبا " كانت عبارةُ النحويين فيه أن يقولوا في " راكب " إِنه حال . وإِذا قال : " الراكب " إِنه صفةٌ جاريةٌ على زيد وإِذا عَرَف في قوله : زيدٌ منطلقٌ أنَّ زيداً مخبرٌ عنه ومنطلقٌ خبرٌ لم يضره أن لا يعلمَ أنَّا نُسمي زيداً مبتدأ . وإِذا عَرَف في قولِنا : ضربتُه تأديباً له أن المعنى في التأديب أنَّه غرضُه من الضرب وأنَّ ضَرَبَه ليتأدبَ لم يضره أن لا يعلمَ أنَّا نسمي التأديب مفعولاً له ولو كان عَدَمُ العلم بهذه العباراتِ يمنعه العلم بما وضعناها له وأردناه بها لكان ينبغي أن لا يكونَ له سبيلٌ إلى بيانِ أغراضه وأن لا يفصلَ فيما يتكلَّم به بين نفي وإِثبات وبين " ما " إِذا كان استفهاماً وبينه إِذا كان بِمعنى الذيوإِذا كان بمعنى المجازاة لأنه لم يسمعْ عباراتِنا في الفرْقِ بين هذه المعاني
أتَرى الأعرابيَّ حين سمع المؤذنَ يقول : أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ الله بالنصب فأنكر وقال : صَنَعَ ماذا أنكَر عن غيرِ علمٍ أن النصبَ يُخْرجُه عن أن يكونَ خبراً ويجعله والأوَّلَ في حُكم اسمٍ واحد وأنه إِذا صار والأولَ في حكم اسم واحدٍ احتيجَ إِلى اسمٍ آخر أو فعل حتى يكونَ كلاماً وحتى يكون قد ذَكَرَ ما لهُ فائدة إِن كان لم يعلمْ ذلك فلماذا قال : صَنَع ماذا فطلب ما يجعلُه خبراً
ويكفيك أنه يلزمُ على ما قالوه أن يكونَ امرؤ القيس حينَ قال :
( قِفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزل ... )
قاله وهو لا يعلَمُ ما نعنيه بقولِنا : إِنّ " قفا " أمرٌ و " نبك " جوابُ الأَمر و " ذكرى " مضافٌ إلى " حبيب " و " منزل " معطوفٌ على الحبيب . وأن تكونَ هذه الألفاظُ قد رتِّبت له من غير قصدٍ منه إِلى هذه المعاني . وذلك يُوجِبُ أن يكون قال : نبْكِ بالجزم من غير أن يكون عرف معنًى يوجبُ الجزم وأتى به مؤخراً عن قفا من غير أن عرف لتأخيرهِ مُوجباً سوى طلبِ الوزن . وَمن أفضتْ به الحالُ إِلى أمثال هذه الشَّناعاتِ ثم لم يرتدِعْ ولم يتبيَّنْ أنه على خطأ فليس إِلاّ تركُه والإِعراضُ عنه
ولولا أنّا نحبُّ أن لا ينبَسَ أحدٌ في معنى السؤال والاعتراض بحرفٍ إلا أريناه الذي استهواهُ لكان تركُ التشاغلُ بإيرادِ هذا وشِبهه أولى . ذاك لأنَّا قد علمنا علمَ ضرورة أنّا لو بقينا الدهرَ الأطولَ نصعِّدُ ونصوِّب ونبحثُ وننقب نبتغي كلمةً قد اتصلتْ بصاحبةٍ لها ولفظَةً قد انتظمت مع أختها من غير أن نتوخَّى فيما بينهما معنًى من معاني النحو طلبنا مُمتنعاً وثَنينا مطايا الفكر ظُلَّعاً . فإِن كان هاهُنا من يشكُّ في ذلك ويزعمُ أنه قد علمَ لاتصالِ الكلم بعضِها ببعض وانتظام الألفاظ بعضِها مع بعض معانيَ غيرَ معاني النحو فإِنَّا نقول : هاتِ فبيِّنْ لنا تلك المعانيوأرِنا مكانها واهدِنا لها فلعلك قد أوتيتَ علماً قد حُجِبَ عنا وفُتِحَ لك بابٌ قد أغلق دوننا - الوافر - :
( وذاكَ لَهُ إِذا العَنْقَاءُ صارَتْ ... مرَبَّبَةً وشَبَّ ابنُ الخَصِيِّ )
فصل في الفصاحة والتشبيه والاستعارة
قد أردت أنْ أعيدَ القولَ في شيءٍ هو أصلُ الفساد ومعظم الآفة والذي صار حِجازاً يبنَ القوم وبين التأمُّل . وأخذ بهم عن طريق النظرِ وحالَ بينهم وبينَ أن يصغوا إِلى ما يقالُ لهم وأن يفتحوا للذي تبيّن أعينُهم وذلك قولهُم : إِن العقلاءَ قد اتفقوا على أنه يَصِحُّ أن يعبَّرَ عن المعنى الواحد بلفظين ثم يكون أحدُهما فصيحاً والآخرُ غيرَ فصيح . وذلك - قالوا - يقتضي أن يكونَ للَّفظ نصيبٌ في المزيَّة لأنها لو كانت مقصورةً على المعنى لكان محالاً أن يُجعلَ لأحد اللفظين فضلٌ على الآخر مع أنَّ المعبَّر عنه واحد . وهذا شيءٌ تراهُم يعجبون به ويُكثرون تردادَه مع أنهم يؤكِّدونه فيقولون : لولا أن الأمرَ كذلك لكان ينبغي أن لا يكونَ للبيت من الشعر فضلٌ عل تفسيرِ المفسِّر له لأنه إِن كان اللفظُ إِنما يشرفُ من أجل معناهُ فإِن لفظَ المفسِّر يأتي على المعنى ويؤديه لا محالة . إِذ لو كان لا يؤدِّيه لكان لا يكونُ تفسيراً له . ثم يقولون : وإِذا لَزِم ذلك في تفسيرِ البيت من الشعر لزم مثلَه في الآية من القرآن . وهم إِذا انتهوا في الحِجاج إِلى هذا الموضع ظنوا أنهم قد أَتَوا بما لا يجوزُ أن يُسْمَعَ عليهم معه كلامٌ وأنَه نقضٌ ليس بعده إِبرامٌ . وربما أخرجَهم الإِعجابُ به إِلى الضحكِ والتعجبِ ممَّنْ يرى أنَّ إلى الكلام عليه سبيلاً وأن يستطيعَ أن يقيمَ على بطلانِ ما قالوه دليلاًوالجواب وبالله التوفيق أن يقالَ للمحتجِّ بذلك : قولُكَ : إِنه يصحُّ أن يعبر عن المعنى الواحد بلفظين يَحْتَمِلُ أمرين :
أحدهما : أن تريدَ باللفظين كلمتين معناهما واحدٌ في اللغة مثلُ : الليثِ والأسَدِ ومثل : شَحَطَ وبَعُدَ وأشباه ذلك مما وُضِعَ اللفظان فيه لمعنى
والثاني : أن تريدَ كلامين . فإِن أردتَ الأولَ خرجتَ من المسألةِ لأنَّ كلامَنا نحن في فصاحةٍ تَحْدُث من بعدِ التأليف دونَ الفصاحة التي توصَفُ بها اللفظةُ مفردةً ومن غير أن
يُعْتَبَرُ حالُها مع غيرها . وإِنْ أردتَ الثاني - ولا بُدَّ لك من أنْ تريدَه - فإِنَّ هاهُنا أصلاً مَنْ عَرَفه عرفَ سقوطَ هذا الاعتراض وهو أن يعلمَ أنَّ سبيلَ المعاني سبيلُ أشكالِ الحُليِّ كالخاتَم والشَّنْف والسِّوار . فكما أنَّ من شأن هذه الأَشكالِ أن يكونَ الواحدُ منها غُفْلاً ساذجاً لم يعمل صانعُه فيه شيئاً أكثرَ من أنْ يأتيَ بما يقعُ عليه اسمُ الخاتم إِن كان خاتماً والشَّنْف إِن كان شَنفاً وأن يكون مصنوعاً بديعاً قد أغربَ صانعُه فيه . كذلك سبيلُ المعاني أن ترى الواحدَ منها غُفلاً ساذجاً عامياً موجوداً في كلام الناس كلِّهم . ثم تراهُ نفسَه وقد عَمَدَ إِليه البصيرُ بشأن البلاغة وإِحداثِ الصُّوَر في المعاني فيصنعُ فيه ما يصنعُ الصَّنَعُ الحاذق حتى يُغرِبَ في الصنعة ويُدِقَّ في العمل ويبدعَ في الصياغة . وشواهدُ ذلك حاضرةٌ لك كيفَ شئتَ وأمثلتُه نُصبَ عينيك من أين نظرتَ تنظرُ إِلى قول الناس : الطَّبعُ لا يتغيَّر ولستَ تستطيعُ أن تخرجَ الإِنسانَ عما جُبِل عليه فترى معنًى غُفلاً عامياً معروفاً في كل جيلٍ وأمة . ثم تنظرُ إِليه في قولِ المتنبي - المتقارب - :
( يُرادُ مِنَ القَلْبِ نِسْيَانُكُمْ ... وتَأْبى الطِّباعُ عَلَى النَّاقِلِ )
فتجدُه قد خَرَجَ في أحسنِ صورة وتراه قد تحوَّل جوهرةً بعد أنْ كان خرزةً وصارَ أعجبَ شيءٍ بعد أنْ لم يكن شيئاً
وإِذ قد عرفتَ ذلك فإِن العقلاءَ إِلى هذا قَصدوا حين قالوا : إِنه يصحُّ أن يعبَّر عن المعنى الواحد بلفظين ثم يكونُ أحدُهما فصيحاً والآخرُ غيرَ فصيح كأنَّهم قالوا : إِنه يصحُّ أنْ تكون هاهنا عبارتان أصلُ المعنى فيهما واحد ثم يكونُ لإِحداهما في تحسينِ ذلك المعنى وتزيينه وإِحداثِ خصوصية فيه تأثيرٌ لا يكونُ للأخرى
واعلمْ أنَّ المخالفَ لا يخلو من أنْ يُنْكِرَ أن يكون للمعنى في إِحدى العبارتين حُسنٌ ومزية يكونان له في الأخرى وأن تَحْدُثَ فيه على الجملة صورةٌ لم تكن أو يعرف ذلك . فإِن أنكرَ لم يكلّم لأنه يؤديه إِلى أن لا يجعلَ للمعنى في قوله
( وتَأْبى الطِّباعُ على النَّاقلِ ... )
مزيةً على الذي يُعْقل من قولهم : الطبعُ لا يتغيَّر ولا يستطيعُ أن يخرجَ الإِنسانُ عما جُبِلَ عليه وأنْ لا يرى لقول أبي نواس - السريع - :
( ولَيْسَ للهِ بِمُسْتَنْكَرٍ ... أن يَجْمَعَ العالمَ في واحِدِ )
مزيّةً على أنْ يقالَ : " غيرُ بديع في قدرةِ الله تعالى أن يجمعَ فضائلَ الخلقِ كلِّهم في رجل واحد " . ومن أدَّاه قولٌ يقول إِلى مثل هذا كان الكلام معه مُحالاً . وكنتَ إِذا كلفتَه أن يعرفَ كمن يكلَّفُ أن يميِّز بحورَ الشعر بعضَها من بعض فيعرفَ المديدَ - الطويل - والبسيطَ - السريع - مَنْ ليس له ذوقٌ يقيمُ به الشعرَ من أصلِه وإِنْ اعترفَ بأن ذلك يكون قلنا له : أخبرنا عنك أتقولُ في قوله :
( وتَأْبى الطِّباعُ على النَّاقِلِ ... )
إِنه غايةٌ في الفصاحة فإِذا قالَ : نعم . قيل له : أوَ كان كذلك عندك من أجل حروفِه أم من أجل حسنٍ ومزية حصلا في المعنى فإِن قال : من أجلِ حروفِه دخلَ في الهذيان . وإِنْ قال : من أجل حسن ومزية حصلا في المعنى قيل له : فذاك ما أردناك عليه حين قلنا إِن اللفظَ يكونُ فصيحاً من أجل مزية تقعُ في معناه لا مِنْ أجل جَرْسه وصَداه
واعلمْ أنَّ ليس شيءٌ أيبنَ وأوضحَ وأحرى أن يكشفَ الشُّبهةَ عن مُتأمِّله في صحةِ ما قلناه من التشبيه فإِنَّك تقول : زيدٌ كالأسد أو شبيهٌ بالأسد . فتجدُ ذلك كلَّه تشبيهاً غُفلاً ساذجاً . ثم تقول : كأن زيداً الأسدُ . فيكونُ تشبيهاً أيضاً . إِلا أنك ترى بينَه وبينَ الأول بَوْناً بعيداً لأنك ترى له صورةً خاصةً وتجدك قد فخَّمتَ المعنى وزدتَ فيه بأن أفدتَ أنه من الشجاعة وشدةِ البطش وأَنَّ قلبَه قلبٌ لا يخامرُه الذعر ولا يدخلُه الروع بحيثُ يتوهَّم أنه الأسدُ بعينه . ثم تقول : لئن لقيتَه ليلقينَّك منه الأسد فتجدُه قد أفاد هذه المبالغةَ ولكن في صورةٍ أحسنَ وصفةٍ أخصَّ وذلك أنك تجعلُه في " كأن " يتوهَّم أنه الأسد وتجعله هاهنا يُرى منه الأسدُ على القطع فيخرجُ الأمر على حدِّ التوهُّم إِلى حدِّ اليقين . ثم إِن نظرتَ إِلى قوله - الطويل - :
( أَأَن أُرعشَتْ كفَّا أَبيكَ وأصبَحَتْ ... يَداكَ يَدَيْ ليثٍ فإِنَّك غالِبُهْ ) وجدته قد بدا لكَ في صورةٍ آنقَ وأحسن . ثم إِن نظرتَ إِلى قولِ أرطاةَ بنِ سُهَيَّة - البسيط - :
( إِنْ تَلْقَنِي لا تَرى غَيْري بناظِرَةٍ ... تَنْسَ السِّلاحَ وتَعْرِفْ جَبْهَةَ الأَسَدِ )
وجدته قد فضلَ الجميع ورأيتَه قد أخرج في صورة غيرِ تلك الصور كلها
واعلمْ أنَّ من الباطلِ والمحالِ ما يعلمُ الإِنسانُ بطلانَه واستحالتَه بالرجوع إِلى النفس حتى لا يَشُكَّ . ثم إِنه إِذا أراد بيانَ ما يجدُ في نفسِه والدلالة عليه رأى المسلكَ إِليه يغمضُ ويدق . وهذه الشُّبهة - أعني قولَهم : إِنه لو كان يجوزُ أن يكونَ الأمرُ على خلافِ ما قالوه من أنَّ الفصاحةَ وصفٌ للفظ من حيث هو لفظٌ لكان ينبغي أنْ لا يكونَ للبيتِ من الشعرِ فضلٌ على تفسيرِ المفسِّر إِلى آخره من ذاك . وقد علقتْ لذلك بالنفوس وقويتْ فيها حتى إِنك لا تلقي إِلى أَحَدٍ من المتعلِّقين بأمرِ اللفظ كلمةً مما نحنُ فيه إِلاّ كان هذا أولَ كلامه وإِلاّ عَجِبَ وقال : إِنَّ التفسيرَ بيانٌ للمفسَّر فلا يجوز أنْ يبقى من معنى المفسَّر شيءٌ لا يؤدِّيه التفسيرُ ولا يأتي عليه لأنَّ في تجويزِ ذلك القول بالمحال وهو أن لا يزالَ يبقى من معنى المفسَّر شيء لا يكون إِلى العلم به سبيلٌ . وإِذا كانَ الأمرُ كذلك ثَبَت أن الصحيحَ من أنه لا يجوزُ أن يكونَ للفظ المفسَّر فضلٌ من حيثُ المعنى على لفظ التفسيرِ . وإِذا لم يَجُزْ أن يكونَ الفضلُ من حيثُ المعنى لم يبقَ إِلا أن يكونَ من حيثُ اللفظ نفسُه . فهذا جملةُ ما يمكِنُهم أن يقولوه في نُصْرةِ هذه الشُّبهة قد استقصيتُه لك . وإِذ قد عرفتَه فاسمع الجوابَ وإِلى الله تعالى الرغبةُ في التوفيق للصواب : اعلم أنَّ قولَهم : إِنَّ التفسيرَ يجب أنْ يكونَ كالمفسَّر دعوى لا تصحُّ لهم إِلا مِنْ بَعْدِ أن يُنكروا الذي بينَّاه من أنَّ من شأن المعاني أنْ تختلفَ بها الصورُ ويدفعوه أصلاً حتى يدّعوا أنه لا فرقَ بينَ الكناية والتَّصريحِ . وأنَّ حالَ المعنى مع الاستعارة كحالهِ مع ترك الاستعارة . وحتى يطلبوا ما أطبقَ عليه العقلاءُ من أن المجازَ يكون أبداً أبلغَ من الحقيقة
فيزعموا أن قولَنا : طويلُ النِّجاد وطويلُ القامة واحدٌ وأنَّ حال المعنى في بيت ابن هَرْمة - المنسرح - :
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وَلا ... أبتاع إلاّ قريبة الأجلِ )
كحالِه في قولك : أنا مضيافٌ . وأنك إِذا قلتَ : رأيتَ أسداً لم يكنِ الأمرُ أقوى من أن تقولَ : رأيتُ رجلاً هو مِنَ الشجاعةِ بحيث لا ينقصُ عن الأسد . ولم تكن قد زدتَ في المعنى بأن ادَّعيتَ له أنه أسدٌ بالحقيقة ولا بالغتَ فيه . وحتَّى يزعموا أنه لا فضلَ ولا مزيةَ لقوله : ألقيتُ حبلَه على غاربه . على قولك في تفسيره : خَلَّيتُهُ وما يريدُ وتركتُه يفعلُ ما يشاء . وحتَّى لا يجعلوا للمعنى في قوله تعالى : ( وأُشْرِبُوا في قُلُوبِهِم العجلَ ) مزيةً على أن يقال : اشتدت محبَّتُهم للعجلِ وغلبتْ على قلوبهم . وأن تكونَ صورةُ المعنى في قولِه عزَّ وجل : ( واشتعلَ الرأسُ شيباً ) صورته في قولِ من يقولُ : وشابَ رأسي كلُّه وابيضَّ رأسي كلّه . وحتّى لا يروا فَرقاً بين قولِه تعالى : ( فما ربِحَتْ تَجَارَتُهم ) وبينَ : فما ربحوا في تجارتِهم وحتى يرتكبوا جميعَ ما أريناك الشناعةَ فيه من أنْ لا يكونَ فرقٌ بين قولِ المتنبي :
( وتَأْبى الطِّباعُ على النَّاقِلِ ... )
وبينَ قولهم : إِنك لا تقدر أن تغيِّر طباعَ الإِنسان . ويجعلوا حالَ المعنى في قولِ أبي نواس :
( ولَيْسَ لله بمستنكرٍ ... أنْ يجمعَ العالمَ في واحدِ )
كحالهِ في قولنا : إِنه ليس ببديعٍ في قدرةِ الله أن يجمعَ فضائلَ الخلق كلِّهم في
واحد . ويرتكبوا ذلك في الكلام كلِّه حتى يزعموا أنَّا إِذا قلنا في قوله تعالى : ( ولكُم في القِصاص حياةٌ ) : أَنَّ المعنى فيها أنه لما كان الإِنسانُ إِذا همَّ بقتلِ آخرَ لشيءٍ غاظه منه فذكرَ أنه إِن قَتَله قُتِل ارتدعَ صار المهمومُ بقتلهِ كأنه قد استفادَ حياةً فيما يستقبلِ بالقصاص . كما قد أدَّينا المعنى في تفسيرنا هذا على صورتِه التي هو عليها في الآية حتى لا نعرفَ فضلاً . وحتى يكونَ حالُ الآيةِ والتفسيرِ حالَ اللفظتين إِحداهما غريبةٌ والأخرى مشهورة فتفسَّرُ الغريبةُ بالمشهورةِ مثلَ أن تقول مثلاً في الشَّرجب إِنه - الطويل - وفي القِطّ إِنه الكتابُ وفي الدُّسُر إِنه المساميرُ . ومَنْ صار الأمرُ به إِلى هذا كان الكلام معه محالاً
واعلمْ أنه ليس عجيبٌ أعجبَ من حالِ مَنْ يرى كلامين أجزاءُ أحدِهما مخالفةٌ في معانيها لأجزاءِ الآخَرِ ثم يرى أنَّه يَسَعُ في العقل أن يكونَ معنى أحدِ الكلامين مثلَ معنى الآخر سواء حتى يتصدَّى فيقولَ : إِنه لو كانَ يكون الكلامُ فصيحاً من أجلِ مزيَّة تكون في معناه لكان ينبغي أن توجدَ تلك المزية في تفسيرهِ . ومثلُه في العجب أنه ينظر إِلى قوله تعالى : ( فما رَبحتْ تِجارتُهم ) فيرى إِعرابَ الاسم الذي هو التجارةُ قد تغيّر فصار مرفوعاً بعد أن كان مجروراً . ويرى أنه قد حُذِفَ من اللفظ بعضُ ما كان فيه وهو الواوُ في " ربحوا " و " في " من قولنا : في تجارتهم . ثم لا نعلمُ أن ذلك يقتضي أن يكون المعنى قد تغيَّر كما تغير اللفظُ
واعلمْ أنه ليس للحجج والدلائل في صحة ما نحنُ عليه حدٌّ ونهاية . وكلَّما انتهى منه بابٌ انفتح فيه بابٌ آخر . وقد أردتُ أن آخذَ في نوعٍ آخرَ من الحِجاجِ ومن البَسْط والشرحِ فتأمَّلْ ما أكتبُه لك :
اعلمْ أنَّ الكلامَ الفصيحَ ينقسم قسمين : قسمٍ تُعْزى المزيةُ والحسنُ فيه إِلى اللفظِ . وقسمٍ يُعزى ذلك فيه إِلى النَّظم . فالقسمُ الأولُ : الكنايةُ والاستعارةُ والتمثيل الكائن على حدِّ الاستعارة وكل ما كان فيه على الجُملة مجازٌ واتساعٌ وعدولٌ باللفظ عن الظاهر . فما من ضربٍ من هذه الضروب إِلا وهو إِذا وقعَ على الصواب وعلى ما ينبغي أوجبَ الفضلَ والمزيةَ . فإِذا قلتَ : هو كثيرُ رمادِ القِدر . كان له موقِعٌ وحظٌّ من القَبول لا يكون إِذا قلتَ : هو كثيرُ القِرى والضيافة . وكذا إِذا قلتَ : هو طويلُ النجاد كان له تأثيرٌ في النفس لا يكون إِذا قلتَ : هو طويل القامة . وكذا إِذا قلتَ : رأيتُ أسداً . كان له مزية لا تكون إِذا قلتَ : رأيتُ
رجلاً يشبه الأسدَ ويساويه في الشجاعة . وكذلك إِذا قلتَ : أراك تقدِّم رِجلاً وتؤخِّر أخرى . كان له موقعٌ لا يكون إِذا قلتَ : أراكَ تتردَّد في الذي دعوتُك إِليه كمن يقول : أَخرُجُ ولا أَخرجُ فيقدِّم رجلاً ويؤخِّر أخرى . وكذلك إِذا قلتَ : ألقى حَبلَه على غاربه . كان له مأخذٌ من القلب لا يكون إِذا قلتَ : هو كالبعيرِ الذي يُلْقَى حبلُه على غاربه حتى يَرْعَى كيف يشاءُ ويذهبَ حيثُ يريد . لا يجهلُ المزيَّةَ فيه إِلا عديمُ الحسِّ ميِّتُ النفس وإِلا مَن لا يكلَّم لأنه من مبادي المعرفة التي من عَدمِها لم يكن للكلام معه معنى
وإِذ قد عرفتَ هذه الجملةَ فينبغي أنْ تنظرَ إِلى هذه المعاني واحداً واحداً وتعرِفَ محصولَها وحقائقهاوأنْ تنظر أوّلاً إلى الكنايةِ . وإِذا نظرتَ إِليها وجدتَ حقيقتَها ومحصولَ أمرِها أنها إِثباتٌ لمعنًى أنت تعرف ذلك المعنى من طريقِ المعقول دونَ طريقِ اللفظ . ألا ترى أنك لمّا نظرتَ إِلى قولِهم : هو كثرُُ رمادِ القدر وعرفتَ منه أنَّهم أرادوا أنه كثيرُ القِرى والضِّيافة لم تعرفْ ذلك مِنَ اللفظ ولكنك عرفتَه بأن رجعتَ إِلى نفسك فقلتَ : إِنه كلامٌ قد جاء عنهم في المدح ولا معنى للمدح بكثرة الرمادِ . فليس إِلا أَنَّهم أرادوا أن يَدلُّوا بكثرة الرماد على أنه تُنصبُ له القدورُ الكثيرةُ ويطبخ فيها للقرى والضيافة وذلك لأنه إِذا كَثُرَ الطبخُ في القدور كَثُر إحراقُ الحطب تَحتَها . وإِذا كَثُرَ إِحراقُ الحَطَبِ كَثُرَ الرمادُ لا محالة . وهكذا السبيلُ في كلِّ ما كان كنايةً فليس من لَفْظِ الشعر عرفتَ أنَّ ابنَ هَرْمة أرادَ بقوله :
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولا ... أبتاعُ إِلاَّ قريبةَ الأجَلِ )
التمدُّحَ بأنه مضيافٌ . ولكنك عرفتَه بالنظر اللطيف وبأنْ علمتَ أنه لا معنًى للتمدُّح بظاهر ما يدلُّ عليه اللفظُ من قرب أجلِ ما يشتريه فطلبتَ له تأويلاً . فعلمتَ أنه أرادَ أن يشتريَ ما يشتريه للأَضياف . فإِذا اشترى شاةً أو بعيراً كان قد اشترى ما قد دنا أجلهُ لأنه يُذْبحُ ويُنْحرُ عن قريب
وإِذ قد عرفتَ هذا في الكناية فالاستعارةُ في هذه القضية وذاك أن موضوعَها على أنك تُثْبِتُ بها معنًى لا يعرفُ السامع ذلك المعنى من اللفظ . ولكنه يعرفُه من معنى اللفظ . بيانُ هذا أنّا نعلمُ أنك لا تقولُ : رأيتُ أسداً . إِلاَّ وغرضُك أنْ تُثْبِتَ للرجل أنه مساوٍ للأَسد في شجاعته وجرأتِه وشدَّةِ بطشه وإقدامه وفي أَن الذُّعرَ لا يخامِرُه والخوفَ لا يعرضُ له . ثم تعلمُ أنَّ السامعَ إِذا عقَلَ هذا المعنى لم يعقله من لفظ أسدٍ ولكنه يعقله من معناه وهو أنه يَعْلَمُ أنه لا معنى لجعله أسداً مع العلم بأنه رجل إِلاّ أنك أردتَ أنه بَلَغ من شدَّةِ مشابهته
للأسد ومساواته إِياه مبلغاً يُتوهَّم معه أنه أسدٌ بالحقيقة فاعرفْ هذه الجملةَ وأحسِنْ تأمُّلها
واعلمْ أنك ترى الناسَ وكأنهم يرون أنك إِذا قلت : رأيتُ أسَداً وأنت تريدُ التشبيه كنتَ نقلتَ لفظَ أسدٍ عما وُضِعَ له في اللغة واستعملتَه في معنًى غيرِ معناه حتى كأنْ ليس الاستعارةُ إِلاّ أن تعمدَ إِلى اسم الشيءِ فتجعلَه اسماً لشبيههِ وحتى كأنْ لا فصلَ بين الاستعارةِ وبين تَسمية المطرِ سماءً والنَّبتِ غيثاً والمزادةِ راويةً وأشباهِ ذلك مما يوقَع فيه اسمُ الشيء على ما هو منه بسبب . ويذهبون عما هو مركوزٌ في الطِّباع من أنَّ المعنى فيها المبالغةُ وأن يُدَّعى في الرجل أنه ليس برجلٍ ولكنه أسدٌ بالحقيقة . وأنه إِنما يعارُ اللفظُ من بَعْد أن يعارَ المعنى وأنه لا يُشرَك في اسم الأسد إِلا مِنْ بَعْدِ أن يُدْخَلَ في جنس الأَسْد . لا ترى أحداً يعقلُ إِلا وهو يعرفُ ذلك إِذا رجعَ إِلى نفسه أدنى رجوع . ومن أجلِ أن كان الأمرُ كذلك رأيتَ العقلاءَ كلَّهم يثبتون القولَ بأنَّ من شأنِ الاستعارة أن تكونَ أبداً أبلغَ من الحقيقة وإِلا فإِنْ كان ليس هاهُنا إِلا نقلُ اسمٍ من شيءٍ إِلى شيءٍ فمن أين يجبُ - ليتَ شعري - أن تكونَ الاستعارةُ أبلغَ من الحقيقة ويكون لقولنا : رأيت أسداً مزيةٌ على قولنا : رأيتُ شبيهاً بالأسد وقد علمنا أنَّه محالٌ أن يتغيَّر الشيءُ في نفسه بأن ينقلَ إِليه اسمٌ قد وُضع لغيره من بعدِ أن لا يرادَ من معنى ذلك الاسمُ فيه شيء بوجه من الوجوه بل يجعلَ كأنه لم يوضَعْ لذلك المعنى الأصلي أصلاً وفي أيِّ عقل يتصورُ أن يتغير معنى " شبيهاً بالأسد " بأنْ يوضعَ لفظُ أسدٍ عليه وينقل إِليه
واعلمْ أن العقلاءَ بنوا كلامَهم إِذ قاسوا وشبَّهوا على أنَّ الأَشياء تستحقُّ الأسامي لخواصِّ معانٍ هي فيها دون ما عَداها . فإِذا أثبتوا خاصةَ شيءٍ لشيءٍ أثبتوا له اسمه . فإِذا جعلوا الرجلَ بحيث لا تنقُصُ شجاعتُه عن شجاعةِ الأسد ولا يعدَمُ منها شيئاً قالوا : هو أسدٌ . وإِذا وصفوه بالتَّناهي في الخيرِ والخصالِ الشريفة أو بالحسن الذي يَبْهُر قالوا : هو مَلَكٌ . وإِذا وصفوا الشيءَ بغاية الطِّيب قالوا : هو مِسْكٌ وكذلك الحكمُ أبداً . ثم إِنهم إِذا استقصَوْا في ذلك نَفَوْا عن المشبَّه اسمَ جنسِه فقالوا : ليس هو بإِنسانٍ وإِنما هو أسدٌ . وليس هو أدمياً وإِنما هو ملكٌ . كما قال الله تعالى : ( ما هذا بَشَراً إِنْ هَذا إِلاَّ مَلَكٌ
كَريمٌ ) . ثم إِنْ لم يريدوا أَنْ يُخرجوه عن جنسِه جملةً قالوا : هو أسدٌ في صورةِ إِنسان وهو ملكٌ في صورة آدميّ . وقد خَرَجَ هذا للمتنبي في أحسنِ عبارة وذلك في قوله - الخفيف - :
( نحنُ ركبٌ مِلْجنِّ في زيِّ ناسٍ ... فوقَ طَيْرٍ لها شُخُوصُ الجِمَالِ )
ففي هذه الجملة بيانٌ لمن عَقَل أنْ ليستِ الاستعارةُ نقلَ اسم عن شيء إِلى شيءٍ ولكنها ادِّعاء معنى الاسم لشيء . إِذ لو كانتْ نقلَ اسم وكان قولُنا : رأيت أسداً بمعنى رأيتُ شبيهاً بالأسد ولم يكن ادعاءً أنه أسدٌ بالحقيقة لكانَ محالاً أنْ يقالَ : ليس هو بإِنسانٍ ولكنه أسدٌ أو هو أسدٌ في صورةِ إِنسان . كما أنه محالٌ أن يقالَ : ليس هو بإِنسانٍ ولكنه شبيهٌ بأسد أو يقالَ : هو شبيهٌ بأسدٍ في صورة إِنسان
واعلمْ أنه قد كَثُر في كلامِ الناس استعمالُ لفظ النَّقْلِ في الاستعارة . فمِنْ ذلك قولهم : إِن الاستعارةَ تعليقُ العبارة على غير ما وضعتْ له في أصلِ اللغة على سبيل النقل . وقال القاضي أبو الحسن : الاستعارة ما اكتُفي فيه بالاسم المستعارِ عن الأَصلي ونُقِلَتِ العبارةُ فجعِلَت في مكانٍ غيرها . ومن شأن ما غَمَضَ من المعاني ولطُفَ أن يصعُبَ تصويرهُ على الوجه الذي هو عليه لعامَّةِ الناس فيقع لذلك في العبارات التي يعبَّر بها عنه ما يوهِمُ الخطأ . وإِطلاقُهم في الاستعارةِ أنها نقلٌ للعبارة عما وُضِعَتْ له من ذلك فلا يصحُّ الأخذُ به . وذلك أنك إذا كنتَ لا تُطلِقُ اسمَ الأسدِ على الرجل إلاّ من بعدِ أن تُدْخِلَه في جنسِ الأسُود من الجهة التي بيّنا لم تكن نَقَلْتَ الاسمَ عمّا وُضِعَ له بالحقيقة لأنكَ إنما تكون ناقلاً إِذا أنتَ أخرجتَ معناه الأصلي من أن يكونَ مقصودَك ونفضْتَ به يدَك . فأمَّا أن تكونَ
ناقلاً له عن معناه مع إرادةِ معناه فمحالٌ مناقِضٌ
واعلمْ أنَّ في الاستعارةِ ما لا يتصوَّرُ تقديرُ النَّقلِ فيه البتَّةَ وذلك مثلُ قولِ لبيد - الكامل - :
( وغَداةِ رِيحٍ قَدْ كشَفْتُ وقِرَّةٍ ... إِذْ أَصْبَحَتْ بيدِ الشِّمال زِمامُها )
لا خلافَ في أنَّ اليد استعارةٌ . ثم إنك لا تستطيعُ أن تزعمَ أنَّ لفظَ " اليد " قد نُقِلَ عن شيءٍ إلى شيء . وذلك أنه ليس المعنى على أنه شبَّه شيئاً باليد فيمكنك أن تزعُمَ أنه نَقَلَ لفظَ اليد إليه وإنما المعنى على أنه أراد أن يُثبتَ للشِّمال في تصريفها الغداةَ على طبيعتها شَبَه الإِنسان قد أخذَ الشيءَ بيده يقلِّبه ويصرِّفه كيفَ يريد . فلما أثبتَ لها مثلَ فعلِ الإِنسان باليد استعارَ لها اليدَ . وكما لا يمكنك تقديرُ النقل في لفظِ اليد كذلك لا يمكنك أن تجعلَ الاستعارةَ فيه من صفةِ اللفظ . ألا ترى أنه محالٌ أن تقول إنه استعارَ لفظَ اليد للشمال وكذلك سبيلُ نظائره مما تجدُهم قد أثبتوا فيه للشيء عضواً من أعضاء الإِنسان من أجل إثباتهم له المعنى الذي يكون في ذلك العضو من الإِنسان كبيت الحماسة - الطويل - :
( إِذا هَزَّهُ في عَظْمِ قرنٍ تهلَّلَتْ ... نَواجِذُ أفْواهِ المَنايا الضَّواحِكِ )
فإِنه لمّا جعلَ المنايا تضحَكُ جعلَ لها الأفواهَ والنواجذَ التي يكون الضحكُ فيها وكبيت المتنبي - الطويل - :
( خميسٌ بشَرْقِ الأَرْضِ والغَرْبِ زَحْفُهُ ... وفي أُذُنِ الجَوْزاءِ منهُ زَمازِمُ )
لمّا جعلَ الجوزاءَ تسمعُ على عادتِهم في جعل النجومِ تَعقِلُ ووصفِهم لها لما
يُوصَفُ بها الأناسيُّ أثبتَ لها الأذنَ التي بها يكون السمعُ من الأَناسي . فأنتَ الآن لا تستطيعُ أن تزعُمَ في بيت الحماسة أنه استعارَ لفظَ النواجذ ولفظَ الأفواه لأَن ذلك يوجبُ المُحالَ . وهو أنْ يكونَ في المنايا شيءٌ قد شبَّهه بالنواجِذ وشيء قد شبَّهَه بالأفواه . فليس إلاّ أن تقولَ : إنه لمّا ادَّعى أن المنايا تُسَرُّ وتَستَبْشِرُ إِذا هو هزَّ السيفَ وجعلَها لسرورها بذلك تضحُكُ أرادَ أن يبالغَ في الأمر فجعلها في صورةِ مَنْ يضحك حتى تبدوَ نواجذُه من شدَّة السرور . وكذلك لا تستطيعُ أن تزعَم أن المتنبي قد استعارَ لفظَ " الأُذن " لأَنه يوجِبُ أن يكونَ في الجوزاءِ شيءٌ قد أرادَ تشبيهَهُ بالأذن وذلك من شنيع المحال
فقد تبيَّنَ من غيرِ وجه أن الاستعارةَ إنما هي ادِّعاءُ معنى الاسم للشيء لا نقلَ الاسم عن الشيء . وإذا ثبتَ أنها ادعاءُ معنى الاسم للشيء علمتَ أنَّ الذي قالوه من أنها تعليقٌ للعبارة على غير ما وُضعتْ في اللغة ونقلٌ لها عما وُضعتْ له كلام قد تسامحوا فيه لأَنه إذا كانتِ الاستعارةُ ادعاءَ معنى الاسم لم يكن الاسمُ مُزالاً عما وُضِعَ له بل مقَرّاً عليه
واعلمْ أنك تراهم لا يمانِعون إذا تكلَّموا في الاستعارة من أن يقولوا : إنه أرادَ المبالغةَ فجعلَه أسداً بل هم يلجؤون إلى القول به . وذلك صريح في أن الأصلَ فيها المعنى وأنه المستعارُ في الحقيقة وأن قولَنا : استعيرَ له اسمُ الأسد إشارةٌ إلى أنه استعير له معناه وأنه جُعِلَ إياه وذلك أنّا لو لم نقلْ ذلك لم يكن ل " جعل " هاهنا معنى لأن " جعل " لا يصلحُ إلاّ حيث يرادُ إثباتُ صفةٍ للشيء كقولنا : جعلتُه أميراً وجعلتُه لصاً . تريدُ أنك أثبتَّ له الإِمارةَ ونسبته إلى اللصوصية وادَّعيتَها عليه ورميتَه بها . وحكم " جَعَلَ " إِذا تعدَّى إلى مفعولين حكم صيَّر فكما لا تقولُ : صيّرته أميراً إلاّ على معنى أنك أثبتَّ له صفة الإمارة كذلك لا يصحّ أن تقولَ : جعلتُه أسداً إلا على معنى أنك أثبتَّ له معاني الأسد . وأما ما تجدُه في بعض كلامهم من أن " جَعَل " يكونُ بمعنى " سَمَى " فمما تَسامحوا فيه أيضاً لأن المعنى معلومٌ وهو مثلُ أن تجدَ الرجلَ يقولُ : أنا لا أسَمِّيه إنساناً . وغرضُه أن يقول : إني لا أثبتُ له المعاني التي بها كان الإِنسان إنساناً . فأما أن يكون " جعل " في معنى " سمَّى " هكذا غُفلاً فمما لا يخفى فسادُه . ألا ترى أنك لا تجدُ عاقلاً يقول : جعلتُه زيداً بمعنى سميته زيداً ولا يقال للرجل : أجعلْ ابنَك زيداً بمعنى سمِّه زيداً و : ولد لفلان ابن فجعله عبدَ الله أي سماه عبدَ الله
هذا ما لا يشكُّ فيه ذو عقل إذا نظر . وأكثرُ ما يكون منهم هذا التسامحُ أعني قولَهم : إن " جعل " يكون بمعنى " سمَّى " في قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا المَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ
إناثاً ) . فقد تَرى في التفسير أنَّ جعلَ يكون بمعنى سمَّى . وعلى ذاك فلا شُبهةَ في أنْ ليس المعنى على مجرد التسمية ولكنْ على الحقيقة التي وصفتُها لك . وذاك أنهم أثبتوا للملائكة صفةَ الإِناث واعتقدوا وجودَها فيهم . وعن هذا الاعتقاد صَدَرَ عنهم ما صَدَرَ من الاسم أعني إطلاقَ اسمِ البنات . وليس المعنى أنهم وضعوا لها لفظَ الإِناث ولفظَ البناتَ من غير اعتقادِ معنى وإثبات صفة . هذا محال . أَوَلا ترى إلى قولهِ تعالى : ( أَشَهِدوا خلقَهم سَتُكتبُ شَهادتُهُم ويُسْأَلونَ ) فلو كانوا لم يزيدوا على إجراءِ الاسم على الملائكة ولم يعتقدوا إثباتَ صفةٍ لما قال الله تعالى : ( أشَهدوا خلْقَهم ) . هذا ولو كانوا لم يقصِدوا إثباتَ صفةٍ ولم يكنْ غيرَ أن وضعوا اسماً لا يريدون به معنًى لمَا استحقوا إلا اليسير من الذمِّ ولما كان هذا القولُ منهم كفراً . والتفسيرُ الصحيح والعبارة المستقيمة ما قاله أبو إسحاق الزّجاجُ رحِمَه الله فإِنه قال : إن الجعلَ هاهنا في معنى القول والحكمِ على الشيء تقول : " قد جعلتُ زيداً أعلمَ الناسِ " أي وصفتُهُ بذلك وحكمتُ به
ونرجع إلى الغرضِ فنقولُ : فإِذا ثَبَتَ أن ليستِ الاستعارةُ نقلَ الاسم ولكن ادِّعاءَ معنى الاسم . وكنا إذا عَقَلْنا من قولِ الرجل : " رأيتُ أسداً " أنه أرادَ به المبالغةَ في وصفه بالشجاعة وأن يقولَ : إنه من قوة القلب ومن فَرط البسالة وشدّةِ البطش . وفي أن الخوفَ لا يخامرُه والذُّعرَ لا يعرض له بحيث لا ينقُصُ عن الأسد لم نعقِلْ ذلك من لفظ أسدٍ ولكن من ادِّعائه معنى الأسد الذي رآه ثبت بذلك أن الاستعارةَ كالكناية في أنك تعرفُ المعنى فيها من طريقِ المعقول دونَ طريق اللفظ
وإِذْ قد عرفتَ أن طريقَ اعلم بالمعنى في الاستعارةِ والكناية معاً المعقولُ فاعلمْ أنَّ حكمَ التمثيلِ في ذلك حكمُها بل الأمرُ في التمثيلِ أَظهرُ وذلك أنه ليس من عاقلٍ يشُكُّ إذا نظرَ في كتابِ يزيدَ بن الوليد إلى مروان بن محمدٍ حينَ بلغه أنه يتلكَّأُ في بَيْعتِه : " أمّا بَعْدُ فإِني أراك تقدِّم رِجلاً وتؤخرُ أُخرى . فإِذا أتاك كتابي هذا فاعتمدْ على أيتهما شئتَ والسلام " . يعلم أن المعنى أنه يقولُ له : بلغني أنك في أمرِ البَيْعة بين رأيين مختلفينِ
ترى تارة أن تبايعَ وأخرى أن تمتنعَ من البيعة . إِذا أتاك كتابي هذا فاعملْ على أيِّ الرأيين شئتَ وأنه لم يُعرفْ ذلك من لفظِ التقديمِ والتأخيرِ أوْ من لفظِ الرِّجْل ولكنْ بأنْ عَلِم أنه لا مَعْنى لتقديم الرِّجْل وتأخيرها في رَجُلٍ يُدْعى إلى البيعة . وأن المعنى على أنه أراد أن يقولَ : إنَّ مثلك في تردُّدك بين أن تبايعَ وبين أن تمتنعَ مثلُ رجلٍ قائمٍ ليذهبَ في أمرٍ فجعلتْ نفسُهُ تريه تارةً أن الصَّوابَ في أن يذهبَ فجعل يقدِّم رجلاً تارة ويؤخِّر أخرى
وهكذا كل كلامٍ كان ضربَ مَثَلٍ لا يَخْفى على مَنْ له أدنى تمييز أن الأغراضَ التي تكونُ للناس في ذلك لا تُعْرَفُ من الألفاظِ ولكن تكونُ المعاني الحاصلةُ من مجموعِ الكلام أدلةً على الأغراضِ والمقاصِد . ولو كان الذي يكونُ غرضَ المتكلِّم يعلمُ من اللفظ ما كان لقولهم : ضَرَب كذا مثلاً لكذا معنًى . فما اللفظُ يُضرَبُ مثلاً ولكن المعنى . فإِذا قلنا في قولِ النبيِّ عليه السلام : " إيَّاكم وخَضراءَ الدِّمن " إنه ضرب عليه السلام خضراءَ الدِّمن مثلاً للمرأة الحسناء في مَنْبِتِ السُّوء . لم يكن المعنى انه ضَرَبَ لفظَ " خضراء الدِّمن " مثلاً لها . هذا ما لا يظنُّه مَنْ به مَسٌّ فضلاً عن العاقل . فقد زالَ الشَكُّ وارتفعَ في أنَّ طريقَ العلم بما يرادُ إثباتُه والخُبر به في هذه الأجناس الثلاثةِ التي هي الكنايةُ والاستعارةُ والتمثيلُ المعقولُ دونَ اللفظِ من حيثُ يكون القصدُ بالإِثبات فيها إلى معنًى ليس هو معنى اللفظ ولكنَّه معنًى يُستَدلُّ بمعنى اللفظ عليه ويستَنْبَط منه كَنحوِ ما ترى من أنَّ القصد في قولهم : هو كثيرٌ رماد القدر إلى كثرة القِرى . وأنت لا تعرف ذلك من هذا اللفظِ الذي تسمعه ولكنَّك تعرفُه بأن تستدلَّ عليه بمعناه على ما مضى الشرح فيه
وإذْ قد عرفت ذلك فينبغي أن يقالَ لهؤلاء الذي اعترضوا علينا في قولنا إن الفصاحةَ وصفٌ تجب للكلام من أجل مزيَّة تكون في معناه وأنها لا تكونُ وصفاً له من حيث اللفظُ مجرداً عن المعنى واحتجوا بأن قالوا : إنَّه لو كان الكلام إِذا وصف بأنه فصيحٌ كان ذلك من أجل مزية تكون في معناه لوجب أن يكون تفسيرُه فصيحاً مثله : أخبرونا عنكم أترونَ أنَّ من شأنِ هذه الأجناسِ إذا كانت في الكلام أن تكون له بها مزية توجبُ له الفصاحةَ أم لا ترون ذلك فإِنْ قالوا : لا نَرى ذلك . لم يكلَّموا . وإن قالوا : نرى للكلام إذا كانت فيه مزيَّة توجبُ له الفصاحة قيل لهم : فأخبرونا عن تلك المزية أتكونُ في اللفظ أم في المعنى فإِن قالوا :
في اللفظ . دخلوا في الجَهالة من حيث يلزمُ من ذلك أن تكون الكنايةُ والاستعارةُ والتمثيلُ أوصافاً للفظ لأنه لا يُتصوَّر أن تكون مزيَّتُها في اللفظ حتى تكونَ أوصافاً له . وذلك محالٌ من حيثُ يعلَمُ كلُّ عاقل أنه لا يكنَّى باللفظ عن اللفظ وأنه إنما يكَنَّى بالمعنى عن المعنى
وكذلك يَعْلَمُ أنه لا يستعارُ اللفظُ مجرداً عن المعنى ولكن يستعارُ المعنى ثُمّ اللفظ يكون تبعَ المعنى على ما قدَّمنا الشرح فيه . ويعلم كذلك أنه محالٌ أن يُضْرَبَ المثلُ باللفظ وأن يكونَ قد ضُرِبَ لفظ " أراك تُقدم رِجلا وتؤخِّر أخرى " مثلاً لتردُّده في أمر البيعة . وإن قالوا : هي في المعنى قيل لهم : فهو ما أردناكُم عليه فَدَعوا الشكَّ عنكم وانتبهوا من رقدتكم فإِنه علم ضرورَيٌّ قد أدَّى التقسيمُ إليه وكل علمٍ كان كذلك فإِنه يجبُ القطعُ على كلِّ سؤالٍ يسأل فيه بأنه خطأ وأن السائلَ ملبوس عليه
ثم إنَّ الذي يُعْرَفُ به وجهُ دخولِ الغلط عليهم في قولِهم : إنه لو كان الكلامُ يكونُ فصيحاً من أجل مزيةٍ تكون في معناه لوجَبَ أنْ يكونَ تفسيرهُ فصيحاً مثلَه : هو أنك إذا نظرتَ إلى كلامهم هذا وجدتَهم كأنَّهم قالوا إنه لو كان الكلامُ إذا كان فيه كنايةٌ أو استعارةٌ أو تمثيلٌ كان لذلك فصيحاً لوجب أن يكونَ إذا لمْ توجَدْ فيه هذه المعاني فصيحاً أيضاً ذاك لأن تفسيرَ الكناية أن نتركَها ونصرِّحَ بالمكنَى عنه فنقول : إن المعنى في قولهم : هو كثيرُ رمادِ القِدْر أنه كثيرُ القِرى . وكذلك الحكمُ في الاستعارة فإِنَّ تفسيرها أنْ نتركَها ونصرِّحَ بالتشبيه فنقول في " رأيت أسداً " : إنَّ المعنى رأيتُ رجلاً يساوي الأسدَ في الشجاعة . وكذلك الأمرُ في التمثيل لأنَّ تفسيرَه أن نذكرَ المتمثِّل له فنقول في قوله : " أراك تقدِّم رجلاً وتؤخّر أخرى " : إنَّ المعنى أنه قال : أراك تتردَّد في أمر البيعة ! فتقولُ تارة : أفعلُ وتارة لا أفعل كمن يريد الذهاب في وجهٍ فتريهِ نفسُه تارةً أن الصَّوابَ في أن يذهبَ وأخرى أنه في أنْ لا يذهبَ فيقدم رجلاً ويؤخِّر أخرى . وهذا خروجٌ عن المعقول لأنه بمنزلةِ أن تقول لرجل قد نُصبَ لوصفِ علةٍ : إن كان هذا الوصفُ يجب لهذه العلةِ فينبغي أن يجبَ مع عدمها
ثم إنَّ الذي استهواهُم هو أنهم نَظروا إلى تفسير ألفاظ اللغة بعضِها ببعض . فلما رأَوْا اللفظَ إذا فسِّر بلفظ مثل أنْ يقالَ في الشَّرجب : إنه - الطويل - لم يَجُزْ أن يكونَ في المفسِّر من حيثُ المعنى مزية لا تكون في التفسير . ظنوا أن سبيلَ ما نحن فيه ذلك السبيلُ وذلك غلطٌ منهم . لأنهم إنما كان للمفسَّر فيما نحن فيه الفضلُ والمزية على التفسير من حيث كانت
الدلالةُ في المفسَّر دلالة معنى وفي التفسير دلالة لفظٍ على معنى وكان من المركوزِ في الطباعِ والراسخِ في غرائِزِ العقولِ أنه متى أُريدَ الدلالةُ على معنى فترك أنْ يُصرَّح به ويُذكر باللفظ الذي هو له في اللغة وعُمِد إلى معنًى آخر فأشيرَ به إليه وجُعِلَ دَليلاً عليه كان للكلام بذلك حسْنٌ ومزيَّة لا يكونان إذا لم يُصنَعْ ذلك وذُكِرَ بلفظه صريحاً . ولا يكونُ هذا الذي ذكرتُ أنه سببُ فضلِ المفسَّر على التفسير من كونِ الدلالة في المفسَّر دلالةَ معنًى على معنًى وفي التفسير معنًى معلوم يعرفه السامع وهو غيرُ معنى لفظ التفسير في نفسِه وحقيقتِه كما ترى من أنَّ الذي هو معنى اللفظ في قولهم : هو كثيرُ رماد القدر . غير الذي هو معنى اللفظ في قولهم : هو كثيرُ القِرى ولو لم يكن كذلك لم يُتصوَّر أن يكون هاهُنا دلالة معنى على معنى
وإِذ قد عرفتَ هذه الجملة فقد حصلَ لنا منها أن المفسَّر يكون له دلالتان : دلالةُ اللفظ على المعنى ودلالةُ المعنى الذي دلَّ اللفظُ عليه على معنى لفظٍ آخر . ولا يكون للتفسير إلا دلالةٌ واحدةٌ وهي دلالة اللفظ . وهذا الفرقُ هو سببُ أنْ كان للمفسَّر الفضلُ والمزية على التفسير . ومحالٌ أن يكونَ هذا قضيةَ المفسَّر في ألفاظِ اللغة . ذاكَ لأنَّ معنى المفسَّر يكونُ مجهولاً عند السامع ومحالٌ أن يكون للمجهول دلالة . ثم إنَّ معنى المفسَّر يكون هو معنى التفسير بعينه ومحالٌ إذا كان المعنى واحداً أن يكون للمفسَّر فضلٌ على التفسير لأن الفضل كان في مسألتنا بأنْ دلَّ لفظ المفسر على معنى ثم دلَّ معناه على معنى آخرَ . وذلك لا يكونُ مع كونِ المعنى واحداً ولا يتصوَّر
بيانُ هذا أنه محالٌ أن يقالَ إنَّ معنى الشرجب الذي هو المفسِّر يكون دليلاً على معنى تفسيره الذي هو الطويلُ على وِزان قولنا : إن معنى " كثيرُ رمادِ القدرُ " يدلٌُّ على معنى تفسيرِه الذي هو " كثيرُ القِرى " لأَمرين :
أحدهما : أنك لا تفسِّر الشرجبَ حتى يكونَ معناهُ مجهولاً عند السامعِ ومحالٌ أن يكون للمجهول دلالةٌ
والثاني : أن المعنى في تفسيرنا الشرجَب بالطويل ِ أن نُعلِمَ السامعَ أن معناه هو معنى الطويل بعينه . وإِذا كان كذلك كان محالاً أن يقال : إن معناه يدلُّ على معنى الطويل والذي يُعْقَل أن يقالَ إن معناه هو معنى الطويل . فاعرفْ ذلك وانظرْ إلى لعبِ الغَفْلَةِ بالقوم . وإلى ما رأَوا في منامِهم من الأحلام الكاذبةِ . ولو أنهم تركوا الاسْتنامة إلى التقليدِ والأخذ
بالهُوينا وترك النظر . وأشعروا قلوبهَم أنَّ هاهنا كلاماً ينبغي أن يُصْغَى إليه . لعلموا ولعادَ إعجابُهم بأنفسِهم في سؤالِهم هذا وفي سائر أقوالِهم عجباً منها ومن تَطويحِ الظُّنون بها
وإِذْ قد بانَ سقوطَ ما اعترضَ به القومُ وفُحْشُ غلطِهم . فينبغي أن تعلمَ أَنْ ليست المزايا التي تجدُها لهذه الأجناسِ على الكلامِ المتروكِ على ظاهرهِ والمبالغة التي تحسُّها في أنفسِ المعاني التي يقصِد المتكلم بخبرِه إليها ولكنها في طريقِ إثباته لها وتقريره إياها وأنك إذا سمعتَهم يقولون : إنَّ من شأنِ هذه الأجناس أن تُكْسِبَ المعاني مزيةً وفضلاً وتوجِبَ لها شرفاً ونبلاً وأن تفخِّمها في نفوسِ السامعين لا يَعْنون أنفسَ المعاني التي يقصِد المتكلمُ بخبرهِ إليها كالقِرى والشجاعة والتردّد في الرأي وإنما يَعْنون إثباتَها لما تُثْبَتُ له ويُخْبَرُ بها عنه . فإِذا جَعلوا للكناية مزيةً على التَّصريحِ لم يجعلوا تلكَ المزيةَ في المعنى المكنَّى عنه ولكنْ في إثباته للذي ثَبَتَ له . وذلك أنَّا نعلم أنَّ المعاني التي يُقْصَد الخبرُ بها لا تتغيَّر في أَنفُسِها بأن يُكنّى عنها بمعانٍ سواها ويتركَ أن تُذْكَر الألفاظُ التي هي لها في اللغة . ومَنْ هذا الذي يَشُكُّ أن معنى طولِ القامة وكثرةِ القِِرى لا يتغيَّران بأن يكنَّى عنهما بطول النجاد وكثرة رماد القدر وتقدير التغيير فيهما يؤدي إلى أنْ لا تكونَ الكنايةُ عنهما ولكن عن غيرِهما . وقد ذكرتُ هذا في صدرِ الكتاب وذكرتُ أن السَّبَبَ في أنْ كان يكون للإِثبات إذا كان من طريقِ الكنايةِ مزيةٌ لا تكونُ إذا كان من طريقِ التصريح أنك إذا كنيتَ عن كثرةِ القِرى بكثرةِ رمادِ القدر كنتَ قد أثبتَّ كثرةَ القرى بإِثباتِ شاهِدِها ودليلِها وما هُوَ عَلَمٌ على وجودِها . وذلك لا محالةَ يكون أبلغَ من إثباتِها بنفسِها وذلك لأَنه يكونُ سبيلُها حينئذٍ سبيلَ الدعوى تكونُ مع شاهد . وذكرتُ أن السَّببَ في أن كانت الاستعارةُ أبلَغَ من الحقيقةِ أنك إذا ادَّعيتَ للرجل أنه أسدٌ بالحقيقة كان ذلك أبلغَ وأشدَّ في تسويته بالأسد في الشجاعة . وذاكَ لأنَّه أن يكون منَ الأسُود ثم لا تكونُ له شجاعةُ الأسود . وكذلك الحكمُ في التمثيل فإِذا قلتَ : أراك تقدِّم رجلاً وتؤخِّر أخرى كان أبلغَ في إثباتِ التردُّد له من أن تقول : أنتَ كمن يقَدِّم رجلاً ويؤخِّر أخرى
واعلمْ أنه قد يَهْجِسُ في نفسِ الإِنسان شيءٌ يظنُّ من أجلِه أنه ينبغي أن يكونَ الحكْمُ في المزيَّة التي تحدثُ بالاستعارةِ أنها تحدثُ في المثَبت دون الإِثبات وذلك أن تقول : إنّا إِذا نظرنا إلى الاستعارةِ وجدناها إنما كانت أبلغَ من أجلِ أنها تدلُّ على قوَّةِ الشَّبه وأنّه قد تَناهَى إلى أن صارَ المشبَّه لا يتميَّزُ عن المشبَّه بهِ في المعنى الذي من أجلهِ شُبِّه به . وإذا كان كذلك كانت المزيَّةُ الحادثةُ بها حادثةً في الشبَهَ وإِذا كانتْ حادِثَةً في الشَبَه كانت في المثَبت دونَ الإِثبات
والجوابُ عن ذلك أن يقالَ إن الاستعارةَ - لعمري - تقتضي قوَّةَ الشبَهَ وكونَه بحيثُ لا يتميَّز المشبَّه عن المشبَّهِ به ولكنْ ليس ذاك سبب المزيةِ وذلك لأنه لو كان ذاك سببَ المزية لكان ينبغي إذا جئتَ به صريحاً فقلتَ : رأيتُ رجلاً مساوياً للأسد في الشجاعةِ وبحيث لولا صورتُه لظننتَ أنك رأيتَ أسداً . وما شاكلَ ذلك من ضروبِ المبالغة أن تجدَ لكلامِك المزيَّةَ التي تجدها لقولِكَ أسداً . وليس يخفى على عاقل أنَّ ذلك لا يكونُ
فإِن قال قائل : إنَّ المزيةَ من أجل أَنَّ المساواةَ تعلم في " رأيتُ أسداً " من طريقِ المعنى وفي " رأيتُ رجلاً مساوياً للأسد " من طريق اللفظ قيل قد قلنا فيما تقدم إنه محال أن يتغيّر حالُ المعنى في نفسه بأنْ يكنَّى عنه بمعنى آخر وأنه لا يُتصوَّر أن يَتغيّر معنى طولِ القامة بأن يكنّى عنه بطول النِجاد ومعنى كثرةِ القِرى بأنْ يكنَّى عنه بكثرةِ الرماد . وكما أن ذلك لا يُتصور فكذلك لا يتصوَّر أن يتغيَّر معنى مساواةِ الرجلِ الأسدَ في الشجاعة بأن يكنَّى عن ذلك ويُدلَّ عليه بأن تجعَله أسداً . فأنتَ الآن إذا نظرتَ إلى قوله - البسيط - :
( فأسْبَلَتْ لُؤلؤاً من نَرْجِسٍ وسَقَتْ ... وَرْدا وعَضَّتْ على العُنَّابِ بالبَرَدِ )
فرأيته قد أفادَكَ أنَّ الدمعَ كان لا يَحْرِمُ من شَبَهِ اللؤلؤ والعينَ من شبهِ النرجس شيئاً - فلا تحسبَنَّ أَنَّ الحسنَ الذي تراه والأريحيَّةَ التي تجدها عنده أنه أفادَكَ ذلك فسحبُ . وذاكَ أنك تستطيعُ أن تجيءَ به صريحاً فتقولَ : فأسبلتْ دمعاً كأَنَّه اللؤلؤ عينِه من عَيْنٍ كأنها
النرجسُ حقيقةً . ثم لا ترى من ذلك الحسنِ شيئاً . ولكن اعلمْ أن سببَ أنْ راقك وأدخل الأريحية عليك أنه أفادك في إثباتِ شدَّةِ الشبه مزيَّة وأوجدكَ فيه خاصّةً قد غُرِزَ في طَبْعِ الإِنسان أن يَرْتَاحَ لها ويجدَ في نفسِه هزَّةً عندها . وهكذا حكمُ نظائِرِه كقولِ أبي نواس - السريع - :
( يَبْكي فَيُذْري الدُّرَّ عَنْ نَرْجِسٍ ... ويَلْطُمُ الوَرْدَ بِعُنَّابِ )
وقولِ المتنبي - الوافر - :
( بَدَتْ قَمَراً ومالَتْ خُوطَ بانٍ ... وفاحَتْ عَنْبَراً وَرَنَتْ غَزالا )
وأعلم أنَّ من شأنِ الاستعارةِ أنك كلّما زدتَ إرادتَك التشبيهَ إخفاءً ازدادتِ الاستعارةُ حسناً . حتى إنك تراها أغربَ ما تكونُ إذا كان الكلامُ قد ألِّف تأليفاً إن أردتَ أن تُفصحَ فيه بالتشبيه خرجتَ إلى شيءٍ تعافُه النفسُ ويلفظُه السَّمعُ . ومثالُ ذلك قولُ ابنِ المعتز - مجزوء الرمل - :
( أَثْمَرَتْ أَغْصانُ راحَتِه ... بِجِنانِ الحُسْنِ عُنَّابا )
ألا ترى أنك لو حملتَ نفسَك على أن تُظهر التشبيهَ وتُفصحَ به احتجتَ إلى أن تقول : أثمرتْ أصابعُ يدهِ التي هيَ كالأغصان لطالبي الحسنِ شبيهِ العنابِ من أطرافِها المخضوبة . وهذا ما تخفى غَثاثته . ومن أجل ذلك كان موقع العنَّاب في هذا البيتِ أحسَنَ منه في قوله :
( وعضَّت على العنّاب بالبَرَدِ ... )
وذاك لأن إظهار التشبيه فيه لا يقْبُحُ هذا القبحَ المفرِط لأنك لو قلتَ : وعضَّتْ على
أطرافِ أصابعٍ كالعنّاب بِثَغْرٍ كالبَرَد كان شيئاً يُتكلَّم بمثله وإن كان مرذولاً . وهذا موضعٌ لا يتبيَّنُ سرَّه إلاّ مَنْ كان ملتَهِبَ الطَّبْعِ حادَّ القريحة . وفي الاستعارةِ علمٌ كثيرٌ ولطائفُ معانٍ ودقائقُ فروقٍ . وسنقولُ فيها إن شاء الله في موضع آخر
واعلمْ أنَّا أخذْنا في الجوابِ عن قولِهم : إنَّه لو كان الكلام يكونُ فصيحاً من أجل مزيَّةٍ تكونُ في معناه لكان ينبغي أن يكونَ تفسيرهُ فصيحاً مثلَه : قلنا إن الكلامَ الفصيحَ ينقسِم قسمين : قسم تُعْزَى المزيةُ فيه إلى اللفظ . وقسمٍ تُعْزَى فيه إلى النظم . وقد ذكرنا في القسمِ الأول من الحُجَجِ ما لا يَبْقى معه لعاقلٍ - إذا هو تأمَّلها - شكٌّ في بُطْلانِ ما تعلَّقَوا به من أنه يلزمُنا في قولِنا : " إنَّ الكلام يكونُ فصيحاً من أجل مزيَّةٍ تكون في معناه " أن يكونَ تفسيرُ الكلامِ الفصيحِ فصيحاً مثلَه . وأنه تهوُّسٌ منهم وتقحُّم في المحالات
وأما القسمُ الذي تُعْزَى فيه المزيَّةُ إلى النَّظمِ فإِنَّهم إنْ ظنوا أنَّ سؤالهَم الذي اغترُّوا به يتجه لهم فيه كان أمرُهم أعجَب وكان جهلُهم في ذلك أغربَ وذلك أنَّ النظم كما بيَّنَّاهُ هو توخّي معاني النحو وأحكامِه وفروقِه وَوجوهه والعملُ بقوانينه وأصولِه وليستْ معاني النحو معاني الألفاظ فيتصوَّر أن يكونَ لها تفسيرٌ
وجملةُ الأمر أنَّ النظمُ إنما هو أنَّ " الحمدَ " من قولِه تعالى : ( الحمدُ لله ربِّ العالمينَ الرَّحمنِ الرحيمِ ) مبتدأُ و " لله " خبر وربِّ صفةٌ لاسم الله تعالى ومضافٌ إلى العالمين والعالمين مضافٌ إليه والرحمن الرحيم صفتان كالربِّ ومالِك من قوله : ( مالِكِ يَوْمِ الدِّين ) صفةٌ أيضاً ومضافٌ إلى يوم و " يومِ " مضافٌ إلى الدين . وإياك : ضميرُ اسم الله تعالى مما هو ضميرٌ يقعُ موقعَ الاسمِ إذا كان الاسمُ منصوباً . معنى ذلك أنَّك لو ذكرتَ اسمَ الله مكانَه لقلتَ : الله نَعبدُ ثم أنَّ " نعبدُ " هو المقتضي معنى النصبِ فيه . وكذلك حكمُ " إياكَ نستعينُ " . ثم إنَ جملةَ " إياك نستعين " معطوفٌ بالواو على جملة " إياك نعبد " . و " الصِّراط " مفعولٌ و " المستقيم " صفةٌ للصراط و " صراط الذين " بدلٌ من الصراط المستقيم " وأنعمتَ عليهم " صلةُ الذين " وغير المغضوب عليهم " صفةُ الذين " والضالين " معطوفٌ على المغضوب عليهم
فانظرِ الآنَ : هل يتصوَّر في شيءٍ من هذه المعاني أن يكونَ معنى اللفظ وهل يكونُ كونُ الحمدِ مبتدأ معنى لفظ الحمد أم يكون كونُ ربِّ صفة وكونه مضافاً إلى العالمين معنى لفظ الرب
فإِنْ قيلَ : إنه إنْ لم تكن هذه المعاني أنفُس الألفاظِ فإِنها تُعْلَمُ على كلِّ حال من ترتيبِ الألفاظِ ومن الإِعرابِ فبالرفع في الدال من الحمد يُعْلَم أنه مبتدأ وبالجرِّ في الباء من ربِّ يعلم أنه صفة وبالياء في العالمينَ يُعْلَم أنه مُضَافٌ إليه . وعلى هذا قياسُ الكُلّ . قيل : ترتيبُ اللفظ لا يكونُ لفظاً والإِعرابُ وإن كان يكونُ لفظاً فإِنه لا يُتصوَّر أن يكونَ هاهنا لفظان كلاهما علامةُ إعراب ثم يكونُ أحدُهما تفسيراً للآخَر . وزيادةُ القولُ في هذا من خَطَل الرأي فإِنه مما يَعْلَمُه العاقلُ ببديهة النظرِ . ومَنْ لَمْ يتنبه له في أوّل ما يسمعُ لم يكن أهلاً لأنْ يكلَّمَ . ونعودُ إلى رأسِ الحديث فنقول :
قد بَطَل الآنَ من كلِّ وجه وكلِّ طريق أن تكون الفصاحةُ وصفاً للفظ من حيثُ هو لفظٌ ونطقُ لسان . وإذا كان هذا صورَةُ الحال وجملةُ الأمر ثم لم ترَ القوم تفكَّروا في شيءٍ مما شرحناه بحالٍ ولا أخطروه لهم ببالٍ بانَ وظهر أنَهم لم يأتوا الأمرَ من بابه ولم يطلبوه من مَعْدِنه ولم يسلكوا إليه طريقَه . وأنَّهم لم يزيدوا على أنْ أَوهموا أنفسَهم وهماً كاذباً أنهم قد أبانوا الوجهَ الذي به كان القرآنُ معجزاً والوصفَ الذي به بانَ من كلام المخلوقين من غيرِ أن يكونوا قد قالوا فيه قولاً يَشْفي من شاكٍ غليلاً ويكون على علمٍ دليلاً وإلى معرفة ما قصدوا إليه سبيلاً
واعلمْ أنَّه إذا نظرَ العاقلُ إلى هذه الأدلَّة فرأى ظهورَها استبعَدَ أن يكونَ قد ظنَّ ظانٌّ في الفصاحةِ أنَّها من صفةِ اللفظ صريحاً . ولعمري إنه كذلك ينبغي إلاَّ أنَّا ننظرُ إلى جِدِّهم وتشدُّدِهم وبَتِّهم الحكمَ بأن المعاني لا تتزايدُ وإنما تتزايدُ الألفاظ . فلئن كانوا قد قالوا الألفاظَ وهم لا يريدونها أنفسَها وإنما يريدون لطائفَ معانٍ تُفْهَم مِنْها لقد كان ينبغي أن يتبعوا ذلك من قولِهم ما ينبىء عن غَرضَهم وأن يذكروا أنَّهم عَنوا بألفاظ ضرباً من المعنى وأن غرضَهم مفهوم خاص
هذا وأمرُ النظم في أنه ليس شيئاً غيرَ توخّي معاني النحو فيما بين الكلم وأنك ترتبُ
المعاني أولاً في نفسِك ثم تحذو على ترتيبها الألفاظَ في نطقِك . وإنَّا لو فَرَضْنا أن تخلوَ ألفاظُ من المعاني لم يتصوَّر أنْ يجبَ فيها نظمٌ وترتيبٌ في غاية القوَّة والظهورِ . ثم ترى الذين لَهَجوا بأمر اللفظ قد أبَوا إلاّ أَنْ يجعلوا النظمَ في الألفاظِ . فترى الرجلَ منهم يرى ويعلمُ أن الإِنسانَ لا يستطيع أن يجيءَ بالألفاظ مرتَّبة إلاّ من بعد أن يفكرَ في المعاني ويرتِّبها في نفسه على ما أعلمناك ثم تفتِّشُه فتراه لا يعرفُ الأمرَ بحقيقته وتراه ينظرُ إلى حالِ السامع . فإِذا رأى المعاني لا تقعُ مرتَّبةً في نفسه إلاّ من بعدِ أن تقعَ الألفاظ مرتبة في سمعه نسيَ حالَ نفسِه واعتبرَ حالَ مَنْ يسمعُ منه . سببُ ذلك قِصَرُ الهمة وضَعْفُ العناية وتركُ النظرِ والأنسُ بالتقليد . وما يُغْني وضوحُ الدلالةِ معَ مَنْ لا ينظرُ فيها . وإنَّ الصبحَ ليملأُ الأفقَ ثم لا يراهُ النائمُ ومَن قد أطبق جفنه
واعلمْ أنكَ لا ترى في الدنيا علماً قد جرى الأمرُ فيه بديئاً وأخيراً على ما جرى عليه في علم الفصاحة والبيان . أما البديءُ فهو أنَّك لا ترى نوعاً من أنواع العلوم إلاّ وإذا تأملتَ كلامَ الأولين الذين علَّموا الناس وجدتَ لعبارةَ فيه أكثرَ من الإِشارة والتصريحَ أغلبَ من التلويح . والأمرُ في علمِ الفصاحة بالضدِّ من هذا فإِنك إِذا قرأتَ ما قاله العلماءُ فيه وجدتَ جُلَّه أو كلَّه رمزاً ووَحْياً وكنايةً وتعريضاً وإيماء إلى الغرض من وجهٍ لا يفطنُ له إلاّ من غَلغل الفكرَ وأدقَّ النظرَ . ومن يرجعْ من طبعه إلى ألمعيةٍ يَقْوى معها على الغامض ويصلُ بها إلى الخفيِّ حتى كان بسلاً حراماً أن تتجلَّى معانيهم سافرةَ الأوجه لا نقابَ لها وباديةَ الصَّفحةِ لا حجابَ دونَها . وحتى كأنَ الإِفصاحَ بها حرامٌ وذِكرَها إلاّ على سبيل الكناية والتعريض غيرُ سائغ
وأما الأخير فهو أنَّا لم نَرَ العقلاءَ قد رَضُوا من أنفسهم في شيءٍ من العلوم أن يحفظوا كلاماً للأوَّلين ويتدارسوه ويكلِّمُ به بعضهم بعضاً من غير أن يعرِفوا له معنى ويقفوا منه على غَرَضٍ صحيحٍ ويكونَ عندهم - إن يسألوا عنه - بيان له وتفسيرٌ إلاّ علمَ الفصاحة فإِنك ترى طبقاتٍ من الناس يتداولون فيما بينهم ألفاظاً للقدماء وعباراتٍ من غير أن يعرفوا لها معنًى أصلاً أو يستطيعوا إن سُئِلوا عنها أن يذكروا لها تفسيراً يصحُّ
فمن أقربِ ذلك أنك تراهُم يقولون إذا هم تكلَّموا في مزيَةِ كلامٍ على كلامٍ : إنَّ ذلك يكون بجزالةِ اللفظ . وإِذا تكلموا في زيادةِ نظمٍ على نظم : إن ذلك يكونُ لوقوعه على طريقةٍ مخصوصةٍ وعلى وجْهٍ دونَ وجه . ثم لا تجدُهم يفسِّرون الجزالةَ بشيء ويقولون في المرادِ بالطريقةِ والوجهِ ما يَحْلَى منه السامعُ بطائل . ويقرؤون في كتبِ البلغاء ضروبَ كلامٍ قد وصفوا اللفظ فيها بأوصافٍ تعلمُ ضرورةً أنَّها لا ترجع إليه من حيثُ هو لفظٌ ونطقُ لسانٍ وصدى حرفٍ كقولهم : لفظ متمكِّنٌ غيرُ قلق ولا نابٍ به موضعُه . وإنَّه جيِّدُ السَّبْكِ صحيحُ الطابعِ . وإنه ليس فيه فضلٌ عن معناه . وكقولهم : إنَّ من حقِّ اللفظ أن يكونَ طِبقاً للمعنى لا يزيدُ عليه ولا ينقُصُ عنه كقول بعضِ مَنْ وصفَ رجلاً من البلغاء : كانت ألفاظهُ قوالبَ لمعانيه . هذا إذا مدحوه . وقولِهم إذا ذمُّوه . هو لفظٌ معقَّدٌ وإنه بتعقيده قد استهلكَ المعنى وأشباه لهذا . ثم لا يخطُر ببالهم أنه يجبُ أن يطلبَ لما قالوه معنًى وتُعْلَم له فائدةٌ ويجشم فيه فِكْرٌ وأن يُعْتَقَدَ على الجملة أقلُّ ما في الباب أنه كلامٌ لا يصحُّ حملهُ على ظاهره . وأن يكونَ المرادُ باللفظ فيه نطقَ اللسان . فالوصفُ بالتمكُّنِ والقلقُ في اللفظ محالٌ فإِنما يتمكَّن الشيءُ ويعلَق إذا كان شيئاً يثبُتُ في مكان . والألفاظُ حروفٌ لا يوجدُ مِنها حرفٌ حتى يعدَم الذي كان قبله
وقولُهم : متمكِّن أو قلق وصفٌ لِلْكلمة بأسرِها لا حرفٍ حرفٍ منها . ثم إنه لو كان يصحُّ في حروفِ الكلمة أن تكونَ باقية بمجموعها لكان ذلك فيها مُحالاً أيضاً من حيثُ إن الشيءَ إنما يتمكَّن ويقلقُ في مكانه الذي يوجد فيه . ومكانُ الحروف إنما هو الحلقُ والفمُ واللسانُ والشفتان فلو كان يصحُّ عليها أن تُوصَفَ بأنها تتمكن وتقلق لكان يكون ذلك
التمكّن وذلك القلق منها في إمكانها من الحلق والفم واللسان والشفتين . وكذلك قولُهم : لفظٌ ليس فيه فضلٌ عن معناه محالٌ أن يكون المرادُ به اللفظَ لأنه ليس هاهنا اسم أو فعلٌ أو حرفٌ يزيد على معناهُ أو ينقصُ عنه . كيف وليس بالذَّرع وُضِعَتْ الألفاظُ على المعاني وإن اعتبرنا المعاني المستفادةَ من الجمل فكذلك . وذلك أنه ليس هاهنا جملةٌ من مبتدأ وخبر أو فعلٍ وفاعلٍ يحصُل بها الإِثبات أو النفيُ أتمُّ أو أنقصُ مما يحصل بأخرى . وإنما فضلُ اللفظ عن المعنى أن تريدَ الدلالةَ بمعنًى على معنًى فتدخِل في أثناء ذلك شيئاً لا حاجَةَ بالمعنى المدلول عليه إليه . وكذلك السبيلُ ي السبك والطابَع وأشباهِهما لا يَحتمِلُ شيءٌ من ذلك أن يكونَ المرادُ به اللفظُ من حيثُ هو لفظ
فإِن أردتَ الصِّدْقَ فإِنَّك لا ترى في الدنيا شأناً أعجبَ من شأن الناس مع اللَّفظِ ولا فسادَ رأيٍ مازجَ النفوسَ وخامَرها واستحكَمَ فيها وصار كإِحدى طبائعها أغربَ من فسادِ رأيهم في اللَّفظ . فقد بلغ من مَلَكته لهم وقوَّته عليهم أنْ تركَهم وكأنهم إذا نُوظروا فيه أُخِذوا عن أنفسهم وغُيِّبوا عن عقولهم وحِيلَ بينهم وبين أن يكون لهم فيما يسمعونه نظرٌ ويُرى لهم إيرادٌ في الإِصغاء وصدَرٌ . فلست ترى إلاّ نفوساً قد جعلتْ تركَ النظر دأبَها ووصلتْ بالهُوينا أسبابَها . فهي تغترُّ بالأضاليل وتتباعدُ عن التحصيل وتُلقي بأيديها إلى الشّبه وتسرع إلى القول المموَّه
ولقد بلغَ من قلَّة نظرهم أن قوماً منهم لما رأوا الكتب المصنفة في اللُّغةِ قد شاع فيها أن تُوصَفَ الألفاظُ المفردةُ بالفصاحة ورأوا أبا العباس ثعلباً قد سَمَّى كتابه " الفصيح " مع أنه لم يذْكُر فيه إلا اللغهَ والألفاظَ المفردة . وكان محالاً إذا قيل : إِن الشمعَ بفتح الميم أَفصحُ من الشمع بإِسكانه أن يكون ذلك من أجلِ المعنى إذ ليس تفيد الفتحةُ في الميم شيئاً في الذي سُمِّي به . سبقَ إلى قلوبهم أنًَّ حكم الوصف بالفصاحة أينما كان وفي أي شيء كان أن لا يكونَ له مرجعٌ إلى المعنى البتة وأن يكون وصفاً للفظ في نفسه ومن حيثُ هو لفظٌ ونطق لسان . ولم يعلموا أن المعنى في وصف الألفاظ المفردة بالفصاحة أنها في اللغة أثبتُ وفي استعمال الفصحاء أكثرُ أو أنها أجرى على مقاييس اللغةِ والقوانين التي وضعوها وأن الذي هو معنى الفصاحة في أصل اللغة هو الإِبانة عن المعنى بدلالة قولِهم : فصيحٌ
وأعجمُ أفصح الأعجميُّ وفَصْح اللحَّانُ وأَفصحَ الرجلُ بكذا : إذا صرَّحَ به . وأنه لو كان وصفُهم هُوَ لَها من حيثُ هي ألفاظٌ ونطقُ لسان لوجب إِذا وجدتَ كلمة يقال : إِنها فصيحة على صفة في اللفظ أن لا توجد كلمة على تلك الصِفَة إلا وجب لها أن تكون فصيحة وحتى يجب إذا كان " فقهتُ الحديث " بالكسر أفصحَ منه بالفتح أن يكونَ سبيلُ كلِّ فعل مثله في الزِّنَةِ أَنْ يكونَ الكسرُ فيه أفصحَ من الفتح . ثم إنَّ فيما أودعَه ثعلبٌ كتابه ما هو أفصح من أجل أنْ لم يكنْ فيه حرفٌ كان فيما جَعله أَفصحَ منه . مثل إنَّ " وَقَفْتُ " افصحُ من " أوقَفْتُ " أَفَترى أنه حدَث في الواو والقاف والفاء بأن لم يكن معها الهمزة فضيلة وجبَ لها أن تكونَ أَفصحَ وكفى برأيٍ هذا مؤدّاه تهافُتاً وخَطَلاً
وجملةُ الأمر أنه لا بُدَّ لقولنا : " الفصاحة " من معنى يُعْرَفُ فإِن كان ذلك المعنى وصفاً في ألفاظِ الكلمات المفردة فينبغي أن يُشارَ لنا إليه وتوضَعَ اليدُ عليه ومن أبينِ ما يَدُلُّ على قِلِّةِ نظرهم أنه لا شُبهةَ على من نظر في كتابٍ تُذْكَرُ فيه الفصاحةُ أن الاستعارةَ عنوانُ ما يُجْعَلُ به اللفظُ فصيحاً وأن المجازَ جملتُه والإِيجاز من معظم ما يوجِبُ للَّفْظِ الفصاحَةَ . وأنت تراهم يذكرون ذلك ويعتمِدونه . ثم يذهبُ عنهم أن إيجابَهم الفصاحةَ للفظِ بهذه المعاني اعترافٌ بصحَّةِ ما نحن ندعوهم إلى القولِ به من أنه يكونُ فصيحاً لمعناه
أما الاستعارةُ فإِنهم إنْ أَغفلوا فيها الذي قلناه من أن المستعارَ بالحقيقة يكون معنى اللفظِ واللفظُ تَبَعٌ مِنْ حيثُ إنَّا لا نقول : رأيتُ أسداً ونحن نعني رجلاً إلاّ على أنَّا ندَعي أنَّا رأينا أسداًَ بالحقيقة من حيثُ نجعلُه لا يتميَّز عن الأسد في بأسِه وبَطْشِهِ وجراءةِ قلبه . فإِنهم على كلِّ حال لا يستطيعون أن يجعلوا الاستعارَةَ وصفاً للفظِ من حيثُ هو لفظٌ مع أَنَّ اعتقادَهم أنك إذا قلتَ : رأيتُ أسداً كنت نقلتَ اسمَ الأسدِ إلى الرجلِ أَوْ جعلتَه هكذا غُفلاً ساذجاً في معنى شجاع . أَفَترى أنَّ لَفْظَ الأسدِ لمّا نُقِلَ عن السَّبُعِ إلى الرجل المشبَّه به أحدثَ هذا النقلُ في أجراسِ حروفهِ ومذاقَتِها وصفاً صارَ بذلك الوصفِ فصيحاً ثم إن من الاستعارة قَبيلاً لا يصحُّ أنْ يكونَ المستعارُ فيه اللفظَ البتَّةَ ولا يصحُّ أن تقعَ الاستعارةُ فيه إلاّ على المعنى وذلك ما كان مثلَ اليد في قول لبيد - الكامل - :
( وغداةِ ريحٍ قد كَشَفْتُ وقِرَّةٍ ... إذْ أصْبَحتْ بيدِ الشِّمال زِمامُها )
ذاكَ أنه ليس هاهنا شيءٌ يَزْعُم أَنَّه شَبَّهه باليد حتى يكون لفظ اليد مستعاراً له . وكذلك ليس فيه شيءٌ يُتَوهَّم أن يكونَ قد شبَّهه بالزِّمام وإنما المعنى على أنه شَبَّه الشِّمالَ في تصريفها الغداةَ على طبيعتها بالإِنسان يكون زمامُ البعير في يَدِه . فهو يُصرِّفُه على إرادته . ولما أراد ذلك جعلَ للشمال يداً وعلى الغداة زماماً . وقد شرحتُ هذا قَبْلُ شرحاً شافياً
وليس هذا الضربُ من الاستعارة بدون الضربِ الأولِ من إيجاب وصفِ الفصاحةِ للكلام لا بَلْ هو أقوى منه في اقتضائها . والمحاسنُ التي تظهرُ به والصورُ التي تحدُث للمعاني بسببه آنقُ وأعجبُ . وإنْ أردتَ أن تَزْداد علماً بالذي ذكرتُ لك من أمره فانظُر إلى قوله - الرجز - :
( سَقَتْهُ كَفُّ اللَّيلِ أكْؤُسَ الكرى ... )
وذلك أنه ليس يَخْفَى على عاقلٍ أنه لم يُرِدْ أن يشبِّه شيئاً بالكفِّ ولا أرادَ ذلك في الأكؤسِ . ولكن لَمّا كان يقالُ : سُكْرُ الكَرى وسكْرُ النوم واستعار للكرى الأكؤسَ كما استعارَ الآخَرُ الكأسَ في قوله - البسيط - :
( وقد سقى القومَ كأسَ النَّعسةِ السَّهَرُ ... )
ثم إنه لما كان الكرَى يكونُ في الليل جعلَ الليلَ ساقياً . ولما جعلَه ساقياً جعلَ له كفّاً إذْ كان الساقي يناوِلُ الكأس بالكفّ . ومن اللَّطِيفِ النادِرِ في ذلَك ما تراهُ في آخِرِ هذه الأبياتِ وهي للحكم بن قَنْبر - الطويل
( ولَوْلا اعْتِصامي بالمُنَى كلَّما بَدا ... ليَ اليأسُ منها لم يَقُمْ بالهَوى صَبْري )
( ولَوْلا انْتِظاري كُلَّ يَوْمٍ جَدا غدٍ ... لراحَ بِنَعْشِي الدّافِنونَ إلى قَبْري )
( وقَدْ رابَني وَهْنُ المُنى وانْقِباضُها ... وبَسْطُ جديدِ اليأسِ كَفَّيه في صدري )
ليس المعنى على أنه استعارَ لفظَ الكفَّينِ لشيءٍ ولكن على أنه أرادَ أن يَصِفَ اليأسَ بأنَّه قد غَلَبَ على نفسه وتمكَّن في صدره . ولما أرادَ ذلك وصفه بما يصفونَ به الرجلَ بفضلِ القدرة على الشيء وبأنه متمكِّن منه وأنه يَفْعلُ فيه كلَّ ما يريد كقولهم : قد بَسَطَ يديه في المالِ ينفِقهُ وصنعُ فيه ما يشاء . وقد بَسَطَ العاملُ يَدَه في الناحية وفي ظُلمْ الناس فليس لك إلاَّ أَنْ تقول إنه لما أراد ذلك جعل لليأس كفين واستعارهما له فأما أن تُوقِعَ الاستعارةَ فيه على اللفظ فمما لا تخفى استحالَتُه على عاقل
والقولُ في المجازِ هو القولُ في الاستعارة لأنَّه ليس هو بشيءٍ غيرِها . وإنما الفرقُ أنَّ المجاز أعمُّ من حيثُ إنَّ كلَّ استعارةٍ مجازٌ وليس كلُّ مجاز استعارة . وإِذا نظرنا من المجاز فيما لا يطلقُ عليه أنه استعارة ازداد خطأُ القوم قبحاً وشناعة وذلك أنه يلزم على قياس قولهم أن يكون إنما قولُه تعالى : ( هو الذي جَعَلَ لكم الليلَ لتَسْكُنوا فيه والنَّهارَ مُبْصِراً ) أفصحَ من أَصْلِه الذي هو قولنا : والنهارَ لتبصروا أنتم فيه أو مبصراً أنتم فيه من أجل أنه حدَثَ في حروفِ مُبْصر - بأن جَعَل الفعلَ للنهارِ على سعَةِ الكلام - وصفٌ لم يكن . وكذلك يلزمُ أن يكونَ السببُ في أَنْ كان قول الشاعر - الرجز - :
( فنام لَيْلي وتجلَّى همّي ... )
أفصحَ من قولنا : فنمتُ في ليلي . أنْ كَسَبَ هذا المجازُ لفظَ الليل مذاقَةً لم تكُنْ لهما . وهذا مما يَنْبغي للعاقل أن يستحيَ منه وأَنْ يأنَفَ مِنْ أن يُهْمِلَ النظرَ إهمالاً يؤديه إلى مثلِه . ونسألُ اللهَ تعالى العِصْمةَ والتوفيقَ
وإِذا قد عرفتَ ما لَزِمهم في الاستعارة والمجاز فالذي يلزَمُهم في الإِيجاز أعجب وذلك أنه يلزمُهم إنْ كان اللفظُ فصيحاً لأَمْرٍ يَرجع إليه نفسُه دونَ معناه أن يكون كذلك موجزاً
لأمْرٍ يرجعُ إلى نفسِه وذلك من المحال الذي يُضْحَك منه لأنه لا معنى للإِيجاز إلا أنّ يدلَّ بالقليل منَ اللَّفظِ على الكثيرِ من المعنى . وإِذ لم تجعلْه وصفاً للفظ من أجلِ معناه أبطلتَ معناه أعني أبطلتَ معنى الإِيجاز
ثم إنَّ هاهنا معنًى شريفاً قد كان ينبغي أن نكونَ قد ذكرناه في أثناءِ ما مضى من كلامِنا وهو أن العاقلَ إذا نَظَر عَلِمَ عِلْمَ ضرورةٍ أنه لا سبيلَ له إلى أن يُكْثِرَ معانيَ الألفاظَ أو يُقَلِّلَها لأنَّ المعانيَ المودعةَ في الألفاظ لا تتغيرُ على الجملةِ عمَّا أرادَه واضعُ اللغة . وإِذا ثَبتَ ظَهَرَ منه أنه لا معنى لقولنا : كثرةُ المعنى مع قلَّةِ اللفظ غير أنَّ المتكلِّم يَتوصَّلُ بدلالة المعنى على المعنى إلى فوائِدَ لَوْ أنَّه أراد الدلالةَ عليها باللفظ لاحتاجَ إلى لفظٍ كثير
واعلمْ أن القولَ الفاسدَ والرأيَ المدخولَ إِذا كان صدورُه عن قوم لهم نَبَاهة وصيتٌ وعلوُّ منزلةٍ في أنواعٍ من العلوم غير العلم الذي قالوا ذلك القولَ فيه ثم وقَعَ في الألسنِ فتداولتْه ونشرتْه وفشاً وظهِرَ وكَثُر الناقلون له والمُشيدون بذكره وصارَ تركُ النظر فيه سُنةً والتقليدُ ديناً . ورأيت الذين هم أهلُ ذلك العلم وخاصتهُ والممارسون له والذين هم خلقاءُ أنْ يعرفوا وَجْهَ الغلطِ والخطأ فيه - لو أنَّهم نظروا فيه - كالأجانب الذين ليسوا من أهله في قبوله والعملِ به والركونِ إليه ووجدْتَهم قد أعطوه مقادتهم وألانوا لهُ جانِبَهم أو أَوْهَمهم النظرُ إلى منتماهُ ومنتَسبهِ ثم اشتهارُه وانتشارُه وإطباقُ الجمع بعدَ الجمع عليه أن الضَّنَّ به أصوبُ والمحاماةَ عليه أولى . ولربما بل كلَّما ظنوا أنه لم يَشِعْ ولم يَتَّسعْ ولم يَرْوِهِ خلفٌ عن سَلَف وأخِرُ عن أول إلاّ لأن له أصلاً صحيحاً وأنه أُخِذَ من مَعدن صدقٍ واشتُقَّ من نَبعةٍ كريمةٍ وأنه لو كان مدخولاً لظهر الدَخَلُ الذي فيه على تقادُم الزمان وكرورِ الأيام . وكمْ من خطأ ظاهرٍ ورأيٍ فاسدٍ حَظِيَ بهذا السببِ عندَ الناس حتّى بَوَّؤوه في أخصِّ موضع من قلوبهم ومنحوه المحبَّة الصادقةَ من نفوسهم وعطفوا عليه عطفَ الأمِّ على واحِدِها . وكم من داءٍ دَويٍّ قد استحكم بهذه العلَّةِ حتى أعيا علاجُه وحتى بَعِلَ به الطبيبُ . ولولا سلطانُ هذا الذي وصفتُ على الناس ون له أخْذَةً تمنع القلوبَ عن التدبُّر وتقطعُ عنها دواعي التفكُّر لما كان لهذا الذي ذهبَ إليه القوم في أمرِ اللفظِ هذا التمكّنُ وهذه القوةُ
ولا كان يرسَخُ في النفوس هذا الرسوخُ وتتشعَّبُ عروقُه هذا التشعُّبَ مع الذي بانَ من تهافُتهِ وسقوطِه وفُحش الغلط فيه وأنك لا ترى في أديمِهِ من أينَ نظرتَ وكيفَ صرفت وقلَّبتَ مصَحَّا وَلا تراه باطلاً فيه شَوْبٌ من الحقِّ وزَيفاً فيه شيءٌ من الفِضَّة ولكن ترى الغشَّ بحتاً والغلط صرفاً ونسأل الله التوفيق
وكيف لا يكونُ في إسارِ الأُخْذَةِ ومحولاً بينه وبين الفكرة مَن يسلِّم أن الفصاحةَ لا تكونُ في أفرادِ الكلماتِ وأنها إنما تكونُ فيها إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض ثم لا يعلم أنّ ذلك يقتضي أن تكونَ وصفاً لها من أجل معانيها لا مِنْ أجلِ أنفُسِها ومن حيثُ هي ألفاظٌ ونطقُ لسانٍ ذاكَ لأنّه ليس مِنْ عاقلٍ يفتح عينَ قلبه إلاّ وهو يَعْلَمُ ضرورةَ أن المعنى في ضَمِّ بعضِها إلى بعض تعليقُ بعضِها ببعض وجعلُ بعضِها بسبب من بعض لا أنْ ينطقَ ببعضها في إثر بعضِ من غير أن يكون فيما بينها تعلُّق ويعلم كذلك ضرورة - إِذا فَكَّر - أنَّ التعلُّقَ يكونُ فيما بين معانيها لا فيما بينها أنفُسِها . ألا ترى أنَّا لو جَهَدنا كلَّ الجَهد أنْ نتصوَّر تعلقاً فيما بينَ لفظين لا معنى تحتهما لم نتصوَّر
ومن أجل ذلك انقسمتِ الكَلِمُ قسمَيْنِ : مُؤْتَلفٍ وهو الاسم مع الاسمِ والفعلُ مع الاسمِ . وغيرِ مؤتلفٍ وهو ما عدا ذلك كالفعل معَ الفعلِ والحرفِ مع الحرف . ولو كان التعلُّقُ يكونُ بين الألفاظِ لكان ينبغِي أنْ لا يختَلِفَ حالُها في الائتلافِ وأنْ لا يكونَ في الدنيا كلمتانِ إلاّ ويصحُّ أن يأتلفا لأنه لا تَنافي بينهما من حيثُ هي ألفاظٌ . وإذا كان كلُّ واحدٍ منهم قد أَعطى يدَه بأن الفصاحةَ لا تكونُ في الكلم أفراداً وأنها إنما تكون إذا ضُمَّ بعضُها إلى بعض . وكان يكونُ المرادُ بضَمِّ بعضِها إلى بعضٍ تعليقَ معانيها بعضِها ببعضٍ لا كونَ بعضِها في النُّطقِ على أثرِ بعض وكان واجباً إذا عَلِم ذلك أن يعلمَ أنَّ الفصاحةَ تجبُ لها من أجل معانيها لا من أجل أنفُسِها لأنه محالٌ أن يكونَ سببَ ظهورِ الفصاحةِ فيها تعلقُ معانيها بعضِها ببعضٍ . ثم تكون الفصاحةُ وصفاً يجب لها لأنفسها لا لمعانيها . وإِذا كان العلم بهذا ضرورةً ثم رأيتَهم لا يعلمونه . فليس إلا أن اعتزامَهم على التقليد قد حالَ بينهم بين الفكرة وعرضَ لهم منه شبهُ الأُخذة
واعلم أنكَ إِذا نظرتَ وجدتَ مثَلَهم مثلَ مَنْ يرى خيالَ الشيء فيحسبُه الشيءَ . وذاك
أنّهم قد اعتمدوا في كلِّ أمرِهم على النَّسقِ الذي يَرونه في الألفاظِ وجعلوا لا يحفلون بِغيره ولا يُعوِّلون في الفصاحةِ والبلاغة على شيء سواه حتى انْتَهوْا إلى أنْ زعموا أنَّ من عمَدَ إلى شعرٍ فصيح فقرأه ونطقَ بألفاظِه على النَّسَقِ الذي وضعها الشاعرُ عليه كان قد أتى بمثل ما أتى به الشاعرُ في فصاحته وبلاغته . إلاّ أنهم زعموا أنه يكون في إتيانه به محتذياً لا مبتدئاً
ونحن إذا تأملنَا وجدنا الذي يكونُ في الألفاظِ من تقديمِ شيءٍ منها على شيءٍإنما يقعُ في النفس أنّه نسَق إذا اعتبرنا ما تُوُخِّي من معاني النَّحو في معانيها . فأما مع ترك اعتبار ذلك فلا يقعُ ولا يُتَصوَّر بحال . أفلا ترى أنك لو فرضتَ في قولهِ :
( قِفا نَبْكِ مِنْ ذِكْرى حَبيبٍ ومَنْزِلِ )
أن لا يكون " نَبْك " جواباً للأمْر ولا يكون مُعدًّى بِمنْ إلى " ذكرى " ولا يكونَ " ذكرى " مضافةً إلى " حبيب " ولا يكونَ " منزل " معطوفاً بالواو على " حبيب " لخرجَ ما ترى فيه من التقديم والتأخيرِ عن أن يكونَ نسقاً ذاك لأنَّه إنما يكونُ تقديمُ الشيءِ على الشيءِ نَسقاً وترتيباً إذا كان التقديمُ قد كان لموجبٍ أوجبَ أن يُقدَّمَ هذا ويؤخَّر ذاك . فأما أن يكون مع عدم الموجب نَسقاً فَمحال لأنه لو كان يكونُ تقديمُ اللَّفظِ على اللفظِ من غير أن يكونَ لهُ موجِبٌ نَسقاً لكان يَنبغي أن يكونَ تَوالي الألفاظِ في النُّطق على أيِّ وجهٍ كان نَسقا . حتى إنك لو قلتَ : " نبكِ قفا حبيبِ ذكرى من " : لم تكنْ قد أَعْدَمْتَهُ النسقَ والنظمَ وإنما أعدمْتَه الوزنَ فقط . وقد تَقدَّم هذا فيما مضى ولكنَّا أعدناه هاهنا لأن الذي أخذنا فيه من إسلامِ القوم أنفسهمِ إلى التقليد اقتضى إعادته
واعلمْ أن الاحتذاءَ عندَ الشُّعراءِ وأهلِ العلم بالشِّعرِ وتقديره وتمييزِهِ أن يبتدئىءَ الشاعرُ في معنًى له وغرضٍ أسلوباً - والأسلوبُ : الضربُ مِنَ النَّظمِ والطريقةُ فيه - فيعمدَ شاعرٌ آخرُ إلى ذلك الأسلوبِ فيجيءَ به في شعره فيشبَّهُ بِمَنْ يقطَعُ مِن أديمهِ نعلاً على مثال نعلٍ قد قَطعها صاحبُها فيقال : قدِ احْتذى على مثالِه وذلك مثلُ أَنَّ الفرزدق قال - الطويل - :
( أَتَرجو رُبَيْعٌ أن تجيءَ صِغَارُها ... بخيرٍ وَقدْ أعيا ربيعاً كبارُها )
واحْتَذاه البَعِيثُ فقال - الطويل - :
( أترجو كُليبٌ أن يجيءَ حَديثُها ... بخَيرٍ وقد أعْيا كُليباً قَديمُها )
وقالوا إنّ الفرزدقَ لما سمعَ هذا البيتَ قال من الوافر :
( إِذا ما قُلْتُ قافيةً شروداً ... تنحَّلَها ابنُ حمراءِ العِجانِ ! )
ومثلُ ذلك أنَّ البَعيثَ قال في هذه القصيدة - الطويل - :
( كُليبٌ لِئامُ الناسِ قد يَعْلمونَه ... وأنتَ إذا عُدَّتْ كليبٌ لئيمُها )
وقال البحتريُّ - الطويل - :
بنَو هاشِمٍ في كلِّ شَرْقٍ ومَغْرِبٍ ... كرامُ بني الدُّنيا وأنتَ كَريمُها )
وحكى العسكريُّ في " صنعة الشعرِ " أنّ ابنَ الرومي قال : قال لي البحتري : قولُ أبي نواس - الطويل - :
( ولم أَدْرِ مَنْ هُمْ غيرَ ما شَهِدَتْ لهم ... بشرِقيِّ سابَاطَ الدِّيارُ البَسابِسُ )
مأخوذٌ من قول أبي خِراشٍ الهُذَليّ - الطويل - :
( وَلَمْ أدْرِ مَنْ أَلقى عليه رداءَهُ ... سِوى أنَّهُ قَدْ سُلَّ مِنْ ماجدٍ مَحْضِ )
قال : فقلت : قد اختلف المعنى فقال : أما ترى حذوَ الكلام حذواً واحداً
وهذا الذي كتبتُ من حَلْي الأخذِ في الحَذْو
ومما هو في حَدِّ الخفيِّ قولُ البحتري - الطويل - :
( ولن يَنْقُلَ الحسّادُ مجدَك بَعْدَما ... تَمكَّن رَضْوَى واطمأنَّ مَتالِعُ )
وقولُ أبي تمام - الكامل - :
( ولقد جَهَدتمْ أنْ تُزيلوا عِزّهُ ... فإِذا أَبانٌ قدْ رَسا ويَلَمْلَمُ )
قد احتذى كلُّ واحدٍ منهما على قول الفرزدق - الكامل - :
( فادفَعْ بِكَفِّك إنْ أَردْتَ بناءَنا ... ثَهْلانَ ذا الهضبَات هَلْ يَتَحلْحَلُ )
وجملةُ الأمر أنَّهم لا يجعلونَ الشاعرَ مُحتذياً إلا بما يجعلونه به آخذاً ومُسترقاً . قال ذو الرمة - الوافر - :
( وشِعْرٍ قَدْ أرِقْتُ له غَريبٍ ... أُجنِّبُه المُسانَدَ والمُحالا )
( فَبِتُّ أقيمُهُ وأَقُدُّ مِنهُ ... قَوافِيَ لا أُريدُ لها مِثالا )
قال : يقول : لا أَحذُوها على شيءٍ سمعتُه . فأَمَّا أن يُجعلَ إنشادُ الشعرِ وقراءتُه احتذاءً فممّا لا يعلمُونه . كيف وإذا عَمَد عامدٌ إلى يبتِ شعرٍ فوضعَ مكانَ كُلِّ لفظٍ لفظاً في معناه
كمثلِ أن يقولَ في قوله - البسيط - :
( دَعِ المكارمَ لا تَرْحَلْ لبُغيَتِها ... واقْعُدْ فإِنَّكَ أنتَ الطَّاعِمُ الكاسي )
( ذَرِ المآثِرَ لا تذهبْ لِمَطْلَبِها ... واجلسْ فإِنَّكَ أنتَ الآكلُ اللابسُ )
لم يجعلوا ذلك احتذاءًولم يؤهِّلوا صاحبَه لأن يُسَمّوه مُحتذياً ولكن يسمون هذا الصَّنيعَ سَلْخاً ويرذلُونه ويُسخِّفون المتعاطيَ له . فمن أينَ يجوزُ لنا أن نقول في صبيٍّ يقرأ قصيدةَ امرىء القيس إنه احتذاهُ في قوله : ( فَقُلْتُ لَهُ لمّا تَمطَّى بِصُلْبهِ ... وأَرْدَفَ أَعْجازاً وناءَ بِكَلْكَلِ )
والعجبُ من أنَّهم لم ينظروا فيعلموا أنه لو كان مُنْشِدُ الشعر مُحتذياً لكانَ يكون قائلُ شعرٍ . كما أنَّ الذي يحذو النَّعلَ بالنعلِ يكون قاطعَ نعل . وهذا تقريرٌ يصلحُ لأن يُحْفظَ للمناظرة ينبغي أن يقالَ لمن يزعمُ أنّ المنشدَ إذا أنشدَ شعرَ امرىءِ القيس : كان قد أَتى بمثلهِ على سبيل الاحتذاء : أخبرْنا عنك : لماذا زعمتَ أنَّ المنشدَ قد أتى بمثل ما قاله امرؤ القيس ألأنه نطقَ بأنفُسِ الألفاظِ التي نطقَ بها أم لأنّه راعى النَّسقَ الذي راعاه في النطقِ بها فإِنْ قلتَ : إنّ ذلك لأنه نطقَ بأنفُسِ الألفاظِ التي نطَقَ بها أحلْتَ لأنه إنما يصحُّ أنْ يقالَ في الثاني : إنه أتى بمثل ما أتى به الأول إذا كان الأول قد سبقَ إلى شيءٍ فأحدثَه ابتداءً وذلك في الألفاظ مُحالٌ إِذ ليس يمكنُ أن يقالَ إنّه لم ينطقْ بهذه الألفاظِ التي هي في قوله :
( قفا نَبْكِ مِنْ ذكرى حبيبٍ ومنزلِ ... )
قبلَ امرىءِ القيس أحدٌ . وإن قلتَ : إنَّ ذلك لأنه قد راعى في نطقه بهذه الألفاظِ النَسقَ الذي راعاه امرؤ القيس . قيل : إن كنتَ لهذا قضيتَ في المُنشدِ أنه قد أتى بمثل شعرِه أخبرنا عنك إِذا قلتَ : إن التحدِّي وقَع في القرآن إلى أن يُؤتى بمثله على جهةِ الابتداءِ ما تعني به أتعني أنه يأتي في ألفاظٍ غيرِ ألفاظِ القرآن بمثل التّرتيبِ والنسقِ الذي تراهُ في
ألفاظ القرآن فإِن قال : ذلك أعني . قيل له : أَعلمتَ أنّهُ لا يكون الإِتيان بالأشياء بعضها في إثر بعض على التَّوالي نَسقاً وترتيباً حتى تكونَ الأشياءُ مختلفة في أنفسِها ثم يكونَ للَّذي يجيءُ بها مَضموماً بعضُها إلى بعض غرضٌ فيها ومقصودٌ لا يتمُّ ذلك الغرضُ وذاك المقصودُ إلا بأن يتخيَّر لها مواضعَ فيجعلَ هذا أوّلاً وذاك ثانياً فإِنَّ هذا ما لا شُبهة فيه على عاقل
وإِذا كان الأمرُ كذلك لزمك أن تبيِّنَ الغرضَ الذي اقتضَى أن تكونَ ألفاظُ القرآن منسوقةً النَسقَ الذي تراه . ولا مخلصَ له من هذه المُطالبة لأنّه إذا أبى أن يكونَ المُقتضي والموجب للَّذي تراهُ من النَّسق المعاني وجَعله قد وَجَب لأمرٍ يرجعُ إلى اللّفظ لم تجد شيئاً يُحيلُ الإِعجازُ في وجوبه عليه البتة . اللهم إلا أنه يجعل الإِعجازَ في الوزن ويزعم أن النسقَ الذي تراه في ألفاظ القرآن إنما كان مُعجزاً من أجلِ أنْ كان قد حَدَث عنه ضربٌ من الوزن يُعجِز الخلقَ عن أنْ يأتوا بمثله وإذا قال ذلك لم يمكنه أن يقول : إنَّ التحدّي وقع إلى أن يأتوا بمثله : في فصاحتِه وبلاغتِه . لأن الوزنَ ليس هو من الفصاحةِ والبلاغةِ في شيء إذْ لو كان له مَدْخَلٌ فيهما لكان يجبُ في كلِّ قصيدتين اتفقتا في الوزن أن تَتَّفقا في الفَصاحة والبلاغة . فإِنْ عادَ بعضَ الناس طولُ الإِلف لِما سمع من أنّ الإعجازَ في اللفظ إلى أن يجعلَه في مُجَرَّدِ الوزنِ كان قد دخل في أمر شنيعٍ وهو أن يكونُ قد جعل القرآنَ معجزاً لا مِنْ حيثُ هو كلام ولا بما كان لكلامٍ فضلٌ على كلامٍ فليسَ بالوزن ما كان الكلامُ كلاماً ولا به كان كلامٌ خيراً من كلامٍ
وهكذا السَّبيلُ إن زعمَ زاعمٌ أنّ الوصفَ المُعجزَ هو الجَريانُ والسُّهولة . ثم يعني بذلك سلامتَه من أن تلتقيَ فيه حروفٌ تثقلُ على اللّسان لأنّه ليس بذلك كان الكلامُ كلاماً ولا هو بالذي يتنَاهى أمرُه إن عُدَّ في الفضيلةِ إلى أن يكونَ الأصلَ وإلى أن يكونَ المعوَّلَ عليه في المفاضلة بين كلامٍ وكلام . فما به كان الشاعرُ مُفْلِقاً والخطيبُ مِصْقَعاً والكاتبُ بَليغاً . ورأينا العقلاءَ حيث ذكروا عجزَ العربِ عن معارضةِ القرآن قالوا : إن النبي تحدَّاهم وفيهم الشّعراءُ والخطباءُ والذين يُدلُّون بفصاحةَ اللسان والبَراعةِ والبيان وقوَّةِ القرائح والأذهان والذين أُوتوا الحكمةَ وفصلَ الخِطابِ . ولم نَرهم قالوا : أن النبي عليه السّلام تَحدَّاهُم وهم العارفون بما يَنبغي أن يُصنعَ حتى يسلمَ الكلامُ من أن تلتقيَ فيه حُروفٌ تثقلُ على اللّسان ولَما ذكروا مُعجزاتِ الأنبياء عليهم السّلام . وقالوا : إن الله تعالى قد جعل
معجزةَ كلِّ نبيٍّ فيما كان أَغلبَ على الذين بُعِث فيهم وفيما كانوا يتباهَوْنَ به وكانت عوامُّهم تعظِّم به خواصَّهم . قالوا : إنه لمَّا كان السحرُ الغالبَ على قومِ فرعونَ ولم يكنْ قد استحكم في زمانٍ استحكامَه في زمانه جعل تعالى مُعجزةَ موسى عليه السلام في إبطالِه وتَوهينِه . ولمّا كان الغالبَ على زمانِ عيسى عليه السّلام الطبُّ جعل الله تعالى مُعجزتَه في إبراء الأكْمهِ والأبرصِ وإِحياءِ الموتى . ولما انتهوا إلى ذكرِ نبيّنا محمّدٍ وذِكْرِ ما كان الغالبَ على زمانه لم يذكروا إلا البلاغةَ والبيانَ والتّصرفَ في ضروب النظم
وقد ذكرتُ في الذي تقدمَ عينَ ما ذكرتهُ هاهنا مما يدلُّ على سقوطِ هذا القول . وما دعاني إلى إعادةِ ذكرهِ إلا أنه ليس تهالكُ الناسِ في حديث اللفظ والمحاماةُ على الاعتقاد الذي اعتقدوه فيه وضَنُّ أنفسهم به إلى حدٍّ . فأحببتُ لذلك أن لا أدَع شيئاً ممّا يجوزُ أن يتعلَّق به متعلِّقٌ ويلجأَ إليه لاجىء ويقعَ منه في نَفْسِ سامعٍ شكُّ إلا استقصَيْتُ في الكَشْفِ عن بطلانه
وهاهنا أمرٌ عجيبٌ وهو أنَه معلومٌ لكلِّ من نظر أن الألفاظ من حَيْثُ هي ألفاظٌ وكَلِمٌ ونطقُ لسانٍ لا تختصُّ بواحدٍ دونَ آخر وأنها إنما تختصُّ إذا تُوُخِّيَ فيها النظمُ . وإِذا كان كذلك كان مَنْ رفع النظمَ منَ البين وجَعَلَ الإِعجازَ بجُملته في سهولةِ الحروفِ وجَريانها جاعلاً له فيما لا يصحُّ إضافتهُ إلى الله تعالى وكَفَى بهذا دليلاً على عَدمِ التوفيق وشدَّةِ الضلال عن الطريق
فصل فيه إجمال وعظة
قد بلغنا في مداواة الناسِ مِنْ دائهم وعلاجِ الفسادِ الذي عرضَ في آرائِهم كلَّ مبلغَ وانتهينا إلى كلِّ غاية وأخذنا بهم عَنِ المجاهل التي كانوا يتعسَّفون فيها إلى السَّنَن اللاّحِب ونقلْنَاهم عَنِ الآجنِ المطروقِ إلى النَّميرِ الذي يَشْفي غليلَ الشارِب . ولم نَدَعْ لباطِلِهم عِرْقاً ينبِضُ إلاّ كوَيناه ولا للخلافِ لساناً ينطق إلاّ أَخرسناه . ولم نترك غطاءً كان على بصرِ ذي عقلٍ إلاّ حَسرناه
فيا أيُّها السامعُ لما قلناه والناظرُ فيما كتبناهُ والمتصفحُ لما دوَّناه إن كنتَ سمعتَ سماعَ صادقِ الرّغبة في أن تكونَ في أَمركَ على بصيرةٍ ونظرتَ نظرَ تامِ العنايةِ في أن يوردَ ويَصْدُرَ عن معرفةٍ وتصفّحْتَ تصفُّحَ مَنْ إذا مارَسَ باباً من العلم لم يُقنِعْه إلاّ أن يكونَ على ذِروة السَّنام ويضربَ بالمعلّى من السِّهامِ فقد هُديتَ لضالَّتك وفُتِح الطريقُ إلى بُغْيتك وهي لك الأَداةُ التي بها تبلغُ وأوتيتَ الآلةَ التي معها تصل . فخذْ لنفسِك بالتي هي أملأُ ليديك وأعْوَدُ بالحظ عليك ووازنْ بين حالِك الآن وقد تنبهتَ من رَقدَتكَ وأَفقتَ من غفلتِك وصرتَ تعلمُ - إِذا أنتَ خُضتَ في أمر اللفظ والنظم - معنى ما تذكر وتعلمُ كيف توردُ وتصدرُ وبينها وأنتَ من أمرها في عمياءَ وخابطٌ خبطَ عشواء . قُصاراك أنْ تكرِّرَ ألفاظاً لا تعرفُ لشيءٍ منها تفسيراً وضروبَ كلام للبلغاء إن سُئلتَ عن أغراضهم فيها لم تستطعْ لها تبييناً فإِنَّك تراكَ تطيلُ التعجُّبَ من غفلتك وتكثرُ الاعتذارَ إِلى عقلك من الذي كنتَ عليه طولَ مدَّتِك . ونسألُ الله تعالى أن يجعلَ كلَّ ما نأتيه ونقصدُه ونَنتحيه لوجههِ خالصاً وإلى رضاه عزَّ وجلَّ مؤدياً ولثوابه مُقتضيا وللزُّلفى عنده موجباً بمنّه وفضلِه ورحمته
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في اللفظ والاستعارة وشواهد تحليليَّة للمعنىاعلمْ أنه لما كان الغلطُ الذي دخل على الناس في حديثِ اللفظ كالداء الذي يَسري في العروق ويُفسدُ مزاج البدن وجَبَ أن يتوخَّى دائباً فيهم ما يتوخَّاه الطبيبُ في النَّاقِه من تَعَهُّدِه بما يزيدُ في مُنَّتِه ويُبقيه على صحتِه ويؤمِّنُه النُّكسَ في عِلّته . وقد علمنا أن أصلَ الفسادِ وسَبَبَ الآفة هو ذهابُهم عن أنَّ من شأن المعاني أن تختلف عليها الصُورُ وتحدثَ فيها خواصٌّ ومزايا من بعد أن لا تكونُ فإِنك ترى الشاعرَ قد عمَد إلى معنًى مبتذلٍ فصنعَ فيه ما يصنعُ الصانع الحاذقُ إذا هو أغربَ في صنعةِ خاتِم وعملِ شَنْفٍ وغيرهما من أصناف الحُليِّ . فإِنَّ جهلهم بذلك من حالها هو الذي أغواهُم واسْتَهواهُم وورَّطهم فيما تورَّطوا فيه من الجَهالات وأدَّاهم إلى التعلُّق بالمُحالات وذلك أنَّهم لما جَهلوا شأنَ الصورة وضعوا لأنفُسِهم أساساً وبنوا على قاعدة فقالوا : إنه ليس إِلاّ المعنى واللفظُ ولا ثالثَ . وإنه إذا كان كذلك وجبَ إذا كان لأحدِ الكلامينِ فضيلة لا تكونُ للآخَرِ ثم كان الغرضُ من أحدهما هوَ الغرضَ من صاحبه أن يكونَ مرجعُ تلك الفضيلة إلى اللَّفظ خاصة وأن يكونَ لها مرجعٌ إلى المعنى من حيثُ إنْ ذلك زعموا يؤدِّي إلى التناقضِ وأن يكونَ معناهما متغايراً وغيرَ متغاير معاً . ولما أَقَرُّوا هذا في نفوسهم حَملوا كلامَ العلماء في كلِّ ما نسبوا فيه الفضيلةَ إلى اللفظ على ظاهره وأَبَوْا أن ينظُروا في الأوصافِ التي أتبعوها نسبتَهم الفضيلةَ إلى اللفظ مثل قولهم : لفظٌ متمكِّنٌ غيرُ قلقٍ ولا نابٍ به موضعُه . إلى سائر ما ذكرنْاه قَبْلُ فيعلموا أنَّهم لم يُوجِبوا للفظِ ما أَوجَبُوه من الفضيلةِ وهم يَعْنُون نطقَ اللسان وأجراسَ الحروف . ولكنْ جعلوا كالمُواضعة فيما بَيْنَهم أن يقولوا اللفظَ وهم يُريدون الصورة
التي تحدث في المعنى والخاصة التي حَدثت فيه ويَعْنُون الذي عَناه الجاحظُ حيث قال : وذهب الشيخُ إلى استحسان المعاني والمعاني مطروحةٌ وسطَ الطريق يعرفُها العربيُّ والعجميُّ والحضريُّ والبدويُّ وإنَّما الشِّعْرُ صياغةٌ وضَرْبٌ من التَّصوير . وما يعنونُه إذا قالوا : إنه يأخذ الحديثَ فيشنِّفُه ويقرِّطُه ويأخذ المعنى خرزةً فيردُّه جَوهرةً وعباءةً فيجعلُه ديباجَةً ويأخذُه عاطلاً فيردُّه حالِياً . وليس كونُ هذا مُرادَهم بحيثُ كان ينبغي أن يَخْفَى هذا الخفاءَ ويشتبهَ هذا الاشتباهَ . ولكنْ إذا تعاطَى الشيءَ غيرُ أهلِه وتولَّى الأمرَ غيرُ البصير به أعضلَ الداءُ واشتدَّ البلاء
ولو لم يكن من الدليلِ على أنَّهم لم يَنْحلوا اللفظَ الفضيلةَ وهم يريدونَه نفسه وعلى الحقيقةِ إلاَّ واحدٌ وهو وصفُهم له بأنَّه يزيِّنُ المعنى وأنه حَليٌ له لكان فيه الكفايةُ . وذاك أنَّ الألفاظَ أدلةٌ على المعاني وليس للدليل إلاّ أن يعلمكَ الشيء على ما يكونُ عليه . فأما أن يصيرَ بالدليلِ على صفةٍ لم يكن عليها فمما لا يقومُ في عقلٍ ولا يُتَصوَّر في وهم
ومما إذا تفكَّر فيه العاقلُ أطالَ التعجُّبَ من أمرِ الناس ومن شدَّةِ غفلتهم قول العلماء حيثُ ذكروا الأخذَ والسرقَة : إنَّ من أَخَذَ معنًى عارياً فكَساه لفظاً من عنده كان أحقَّ به . وهو كلامٌ مشهورٌ متداوَلٌ يقرؤه الصِّبيانُ في أوَّلِ كتابِ عبد الرَّحمن . ثم لا ترى أحداً من هؤلاء الذين لهجُوا بجعلِ الفضيلةِ في اللفظ يفكِّرُ في ذلك فيقولُ : من أينَ يتصوَّر أن يكونَ هاهنا معنًى عارٍ من لفظٍ يدلُّ عليه ثم من أينَ يُعْقَلُ أنْ يجيءَ الواحدُ منا لمعنًى من المعاني بلفظٍ مِنْ عنده إن كان المرادُ باللفظ نُطقَ اللسان ثم هَبْ أنَه يصحُّ له أن يفعلَ ذلك فمن أينَ يجبُ إذا وضَعَ لفظاً على معنى أن يصيرَ أحقَّ من صاحِبه الذي أخذَه منه إن كانَ هولا يَصْنَعُ بالمعنى شيئاً ولا يُحْدِثُ فيه صفة ولا يُكسِبُه فضيلةً وإذا كان كذلك فَهَلْ يكونُ لكلامهِم هذا وجهٌ سوى أن يكونَ اللّفظُ في قولِهم : " فكساهُ لفظاً من عنده " عبارةً عن صورةٍ يُحدثها الشاعرُ أو غيرُ الشاعر للمعنى فإِن قالوا : بَلَى يكونُ وهو أنْ يستعيرَ للمعنى لفظاً قيلَ : الشأنُ في أنَّهم قالوا : " إذا أخذَ معنًى عارياً فكساهُ لفظاً من عِنْدِهِ كان أحقَّ به "
والاستعارةُ عندكم مقصورةٌ على مجرَّد اللفظ ولا تَرون المستعيرَ يَصْنَعُ بالمعنى شيئاً وترون أنَّه لا يحدثُ فيه مزيَّةً على وَجْهٍ من الوجوه . وإذا كان كذلك فمن أينَ - ليتَ شِعْري - يكونُ أحقَّ به فاعرفهْ . ثم إنْ أردتَ مثالاً في ذلك فإِنَّ من أحسنِ شيءٍ فيهِ ما صنعَ أبو تمام في بيتِ أبي نُخيْلَةَ . وذلك أن أبا نُخيلةَ قال في مَسلمةَ بنِ عبد الملك - الطويل - :
( أَمَسْلَمُ إنّي يابنَ كلِّ خَليفةٍ ... ويا جَبَلَ الدُّنيا ويا واحدَ الأرضِ )
( شَكَرْتُك إنَّ الشُّكْرَ حَبْلٌ مِنَ التُّقَى ... وما كُلُّ مَن أَوْلَيْتَهُ صالحاً يَقْضِي ) ( وأَنْبَهْتَ لي ذِكْري وما كانَ خامِلاً ... ولكِنَّ بعضَ الذِّكرِ أنبهُ مِنْ بعضِ )
فعَمد أبو تمام إلى هذا البيتِ الأخيرِ فقال - الطويل - :
( لقد زِدْتَ أوْضاحي امْتِداداً ولمْ أكنْ ... بَهيماً ولا أَرْضَى من الأَرْضِ مَجْهلا )
( ولكِنْ أيادٍ صادَفَتْني جِسامُها ... أغَرَّ فأَوفَتْ بي أغَرَّ مُحَجَّلا )
وفي كتاب " الشّعرِ والشُّعراء " للمَرزُباني فصلٌ في هذا المعنى حسنٌ قال : ومن الأمثال القديمة قولهُم : " حَرّاً أخافُ على جاني كَمْأةٍ لا قُرّاً " يُضربُ مثَلاً للذي يخَافُ من
شيءِ فيسلمُ منهُ ويصيبُه غيرهُ مما لم يخَفْه فأخذ هذا المعنى بعضُ الشعراءِ فقال - الكامل - :
( وحَذِرْتُ من أَمْرٍ فَمَرَّ بِجانِبي ... لم يُنْكِني ولَقِيتُ ما لَمْ أَحْذَرِ )
وقال لبيد - المنسرح - :
( أَخْشى عَلى أربَدَ الحُتوفَ ولا ... أرهبُ نَوْءَ السِّماكِ والأسَدِ )
قال : وأخذه البحتريُّ فأحسَن وطغى اقتداراً على العبارةِ واتساعاً في المعنى فقال - الكامل - :
( لو أَنَّني أُوفِي التَّجاربَ حَقَّها ... فيما أَرَتْ لرجوتُ ما أخشاهُ )
وشبيهٌ بهذا الفصل فصلٌ آخرُ من هذا الكتاب أيضاً
أنشدَ لإِبراهيمَ بنِ المهدي - السريع - :
( يا مَنْ لِقَلْبٍ صِيغَ من صَخْرةٍ ... في جَسَدٍ من لُؤْلُؤ رَطْبِ )
( جَرحتُ خدَّيه بلحظي فيما ... بَرِحتُ حتى اقتصَّ مِنْ قلبي )
ثم قال : قالَ عليُّ بنُ هارونَ : أخذه أحمدُ بنُ فَنَن معنًى ولفظاً فقال - الكامل - :
( أَدْمَيْتُ باللَّحَظاتِ وَجْنَتَهُ ... فاقْتَصَّ ناظِرُهُ مِنَ القَلْبِ )
قال : ولكنَّه بنقاءِ عبارتِه وحُسْنِ مأخذهِ قد صارَ أَولى به
ففي هذا دليلٌ لمن عَقَل أنهم لا يَعْنون بحسنِ العبارةِ مجَرَّد اللفظِ ولكن صورةً وصفةً وخصوصيّةً تحدُثُ في المعنى وشيئاً طريقُ معرفته على الجملة العقلُ دون السمع فإِنه على كلِّ حال لم يَقُل في البحتريِّ إنه أحسنَ فطغى اقتداراً على العبارة من أجل حروفٍ لو أنني أوفي التجاربَ حقَّها
وكذلك لم يصِف ابنَ أبي فَنن بنقاءِ العبارةِ من أجلِ حروف :
( أَدْمَيْتُ باللَّحظاتِ وَجْنَتَهُ ... )
واعلمْ أنك إذا سَبرتَ أحوالَ هؤلاءِ الذين زَعموا أنه إذا كان المعبَّرُ عنه واحداً والعبارةُ اثنتين ثم كانتْ إحدى العبارتين أفصحَ من الأخرى وأحسَن فإِنه ينبغي أن يكونَ السببُ في كونها أفصحَ وأحسنَ اللفظَ نفسَه وجدتَهم قد قالوا ذلك من حيث قاسوا الكلامين على الكلمتين . فلما رأَوا أنه إذا قيل في الكلمتين إنَّ معناهُما واحدٌ لم يكن بينهُما تفاوتٌ ولم يكن المعنى في إِحداهما حالٌ لا يكون له في الأخرى ظنُّوا أن سبيلَ الكلامين هذا السبيل . ولقد غَلِطوا فأَفحشوا لأنه لا يُتَصوَّر أن تكونَ صورةُ المعنى في أَحدِ الكلامَينِ أو البيتينِ مثلَ صورته في الآخِر البتّة اللهمَّ إلاّ أن يعمدَ عامِدٌ إلى بيتٍ فيضعَ مَكانَ كُلِّ لفظة منه لفظةً في معناها ولا يعرِضُ لنظمه وتأليفه كمثلِ أن يقولَ في بيت الحُطَيْئَة - البسيط - :
( دَعِ المَكارمَ لا ترحَلْ لِبُغْيتها ... واقعدْ فإِنَّك أنتَ الطاعمُ الكاسي )
( ذَرِ المفاخرَ لا تَذْهَب لِمَطْلَبِها ... واجْلِسْ فإِنّكَ أنتَ الآكِلُ اللابسْ )
وما كان هذا سبيلَه كان بمعزلٍ من أن يكونَ به اعتدادٌ وأن يدخلَ في قبيلِ ما يُفاضَل فيه بين عبارتين بل لا يصحُّ أن يُجْعلَ ذلك عبارةً ثانية ولا أنْ يُجْعَلَ الذي يتعاطاه بمحلِّ من يوصَفُ بأنه أخذ معنى . ذلك لأنه لا يكونُ بذلك صانِعاً شيئاً يستحقُّ أن يُدعى من أجلِه واضعَ كلام ومستأنِفَ عبارة وقائِلَ شعرٍ . ذاك لأنَّ بيتَ الحطيئة لم يكنْ كلاماً وشعراً من أجل معاني الألفاظ المفردة التي تراها فيه مجرَّدةً مُعرَّاةً من معاني النظم والتأليف بل منها متوخًّى فيها ما ترى من كونِ المكارم مفعولاً ل " دع " وكونِ قوله : " لا ترحلْ لبغيتها " جملة
أكَّدت الجملةُ قبلها وكون " اقعدْ " معطوفاً بالواو على مجموعِ ما مضى وكون جملةِ " أنت الطاعِمُ الكاسي " معطوفة بالفاء على " اقعد " . فالذي يَجيء فلا يُغَيِّر شيئاً من هذا الذي به كان كلاماً وشعراً لا يكونُ قد أتى بكلام ثانٍ وعبارةٍ ثانية بل لا يكونُ قد قالَ من عند نفسه شيئاً البتّة
وجملةُ الأمر أنه كما لا تكون الفِضّةُ أو الذَهَب خاتماً أو سِواراً أو غيرَهُما من أصناف الحُليِّ بأنفسِهما ولكن بما يحدثُ فيهما من الصُّورة . كذلك لا تكونُ الكَلِم المفردةُ التي هي أسماءٌ وحروفٌ كلاماً وشعراً من غير أن يحدث فيها النَّظمُ الذي حقيقتُه توخّي معاني النحو وأحكامه . فإِذاً ليس لمن يتصدّى لِما ذكرنا من أن يعمدَ إلى بيتٍ فيضعَ مكانَ كلِّ لفظة منها لفظةً في معناها إلا أن يُسْتَرَكَّ عقلُه ويستخفَّ ويُعَدَّ مَعدَّ الذي حُكيَ أنه قال : إني قلتُ بيتاً هو أشعرُ من بيتِ حسان . قال حسان - الكامل - :
( يُغْشَوْنَ حَتّى ما تَهِرُّ كلابُهم ... لا يَسْأَلُونَ عَنِ السَّوادِ المُقْبِلِ )
وقلتُ :
( يُغْشَونَ حَتَّى ما تَهِرُّ كِلابُهُمْ ... أَبَداً ولا يَسَلُونَ مَنْ ذا المُقْبلُ )
فقيل : هو بيتُ حَسّان ولكنك قد أفسدتَه !
واعلمْ أنه إنما أُتِيَ القومُ من قِلَّة نَظَرِهم في الكُتُب التي وضَعَها العلماءُ في اختلافِ العبارتين على المعنى الواحد وفي كلامهم في أخذِ الشاعرِ مِنَ الشاعرِ وفي أنْ يقولَ الشاعران على الجملةِ في معنىً واحدٍ وفي الأَشعارِ التي دوَّنوها في هذا المعنى . ولو أنهم كانوا أخذوا أنفسَهم بالنظرِ في تلك الكتبِ وتدبّروا ما فيها حقَّ التدبُّر لكان يكونُ ذلك قد أيقظَهم مِنْ غفلتهم وكشَفَ الغطاءَ عن أعينهم
وقد أردتُ أن اكتُبَ جملةً من الشِّعْر الذي أنتَ ترى الشّاعرين فيه قدْ قالا في معنى واحدٍ . وهو يَنقَسِمُ قسمين : قسمٌ أنتَ ترى أحد الشاعرينِ فيه قد أتى بالمعنى غُفلاً ساذجاً وترى الآخرَ قد أخرجَه في صورةٍ تروقُ وتُعْجِبُ . وقسمٌ أنتَ ترى كلَ واحدٍ من الشاعرين قد صَنَعَ في المعنى وصَوَّرَ
وأَبدأُ بالقسمِ الأول الذي يكونُ المعنى في أحدِ البيتين غُفلاً وفي الآخَرِ مصوَّراً مَصنوعاً ويكونُ ذلك إمّا لأَنّ متأخِراً قصر عن متقدِّمِ وإما لأنْ هُدِيَ متأخِّرٌ لشيء لم يهتدِ إليه المتقدِّم ومثالُ ذلك قولُ المتنبي - السريع - :
( بِئْسَ اللَّيالي سَهِدْتُ مِنْ طَرَبي ... شَوْقاً إلى مَنْ يَبيتُ يَرْقُدُها )
مع قول البحتري - الكامل - :
( لَيلٌ يُصادِفُني ومرْهفَةَ الحَشا ... ضِدَّيْنِ أَسْهَرُهُ لَها وَتَنامُهُ )
وقولُ البحتري - البسيط - :
( وَلَوْ وملكتُ زماعاً ظَلَّ يَجْذِبُني ... قَوْداً لَكانَ نَدَى كَفَّيكَ مِنْ عُقُلي )
مع قول المتنبي - الطويل - :
( وَقَيَّدْتُ نَفْسي في ذَراكَ مَحَبَّةً ... وَمَنْ وَجَدَ الإِحْسانَ قَيداً تَقَيَّدا )
وقولُ المتنبي - الكامل - :
( إِذا اعْتَلَّ سَيْفُ الدَّوْلَةِ اعْتَلَّتِ الأَرْضُ ... وَمَنْ فَوْقَها وَالبأْسُ وَالكَرَمُ المَحْضُ )
مع قولِ البحتري - الكامل - :
( ظَلِلْنا نَعُودُ الجُودَ مِنْ وَعْكِكَ الَّذي ... وَجَدْتَ وَقُلْنا : اعْتَلَّ عِضْوٌ منَ المَجْدِ )
وقولُ المتنبي - الكامل - :
( يُعْطيكَ مُبْتَدِئاً فإِنْ أَعْجَلْتَهُ ... أَعْطاكَ مُعْتذِراً كَمَنْ قَدْ أَجْرَما )
مع قولِ أبي تمام - الكامل - :
( أخو عَزَماتٍ فِعلُهُ فِعلُ مُحسنٍ ... إلينا وَلكنْ عُذْرُهُ عُذْرُ مُذْنبِ )
وقولُ المتنبي - الطويل - :
( كَريمٌ مَتَى اسْتُوهِبْتَ ما أنْتَ راكِبٌ ... وَقَدْ لَقِحَتْ حَرْبٌ فإِنَّكَ نازِلُ )
مع قولِ البحتري من البسيط :
( ماضٍ على عَزْمِهِ في الجُودِ لوْ وَهَبَ الشْشباب ... يَوْمَ لِقاءِ البِيضِ ما نَدِما )
وقولُ المتنبي - الخفيف - :
( وَالذي يَشْهَدُ الوَغَى سَاكنَ القلْبِ ... كَأَنَّ القتالَ فيها ذِمامُ )
مع قولِ البحتري - الطويل - :
( لَقَدْ كانَ ذاكَ الجَأْشُ جَأْشُ مُسالمٍ ... على أَنَّ ذاكَ الزِّيَّ زِيُّ مُحارِبِ )
وقولُ أبي تمام - الكامل - :
( الصُّبْحُ مَشْهُورٌ بِغَيْرِ دَلائِلٍ ... مِنْ غيرهِ ابْتُغِيَتْ ولا أَعْلامِ )
مع قولِ المتنبي - الوافر - :
( ولَيْسَ يَصحُّ في الأَذْهانِ شَيْءٌ ... إِذَا احتاجَ النَّهارُ إلى دَليلِ )
وقولُ أبي تمام - الوافر - :
( وَفي شَرَفِ الحديثِ دَليلُ صِدْقٍ ... لِمُخْتَبِرٍ على الشَّرَفِ القَديم )
مع قولِ المتنبي - البسيط - :
( أَفْعالُهُ نَسَبٌ لوْ لمْ يَقُلْ مَعَها ... جَدِّي الخَصيبُ عَرَفْنا العِرْقَ بالغُصُنِ )
وقولُ البحتري - الكامل - :
( وَأَحَبُّ آفاقِ البِلادِ إلى الفتى ... أَرْضٌ يَنالُ بِها كريمَ المَطْلَبِ )
مع قولِ المتنبي - الطويل - :
( وَكُلُّ امْرىءٍ يُولي الجَميلَ مُحبَّبٌ ... وَكُلُّ مَكانٍ يُنْبِتُ العِزَّ طيِّبُ )
وقولُ المتنبي - الطويل - :
( يُقِرُّ لَهُ بِالفَضْلِ مَنْ لا يَوَدُّهُ ... وَيقْضي لَهُ بِالسَّعدِ مَنْ لا يُنَجِّمُ )
مع قولِ البحتري - الكامل - :
( لا أَدَّعي لأَبي العَلاءَ فضيلَةً ... حتَّى يُسلِّمَها إليهِ عِداهُ )
وقولُ خالدٍ الكاتبِ - المتقارب - :
( رَقَدْت وَلمْ تَرثِ للسَّاهِرِ ... وَلَيلُ المُحبِّ بِلا آخرِ )
مع قولِ بَشّار - الطويل - :
( لِخَدِّيكَ مِنْ كَفَّيكَ في كُلِّ ليلةٍ ... إِلى أنْ تَرَى ضَوْءَ الصَّباحِ وِسادُ )
( تَبيتُ تُراعِي اللَّيلَ تَرْجُو نَفادَهُ ... وَليْسَ لِلَيْلِ العاشِقينَ نَفادُ )
وقولُ أبي تمام - الوافر - :
( ثَوَى بالمَشْرقَيْنِ لهمْ ضِجَاجٌ ... أطارَ قلوبَ أَهلِ المغربينِ )
وقولُ البحتري - الطويل - :
( تَناذَرَ أهلُ الشَّرقِ منه وقائعاً ... أطاعَ لها العاصُون في بَلَدِ الغَرْبِ )
مع قولِ مسلم - البسيط - :
( لمّا نزلتَ على أدنى ديارِهمِ ... أَلْقَى إليكَ الأَقاصي بالمقاليدِ )
وقولُ محمد بن بشير - البسيط - :
( افْرُغْ لحاجَتِنا ما دمتَ مشغولاً ... فلو فَرَغْت لكنتَ الدَّهْرَ مَبْذولا )
مع قول أبي عليٍّ البصير - الطويل - :
( فقُلْ لسعيدٍ أسعدَ اللهُ جَدَّه : ... لقد رَثَّ حتى كادَ ينصَرِمُ الحبلُ )
( فلا تعتذرْ بالشُّغْلِ عنا فإِنما ... تُناطُ بك الآمالُ ما اتَّصلَ الشغلُ )
وقولُ البحتري - الكامل - :
( مِنْ غادةٍ مُنعتْ وتمنعُ وصلَها ... فلوَ أنها بُذِلَتْ لنا لم تَبْذُلِ )
مع قولِ ابن الرومي - مجزوء الكامل - :
( ومِنَ البَليَّة أَنَّني ... عُلِّقتُ ممنوعاً مَنوعا )
وقولُ أبي تمام - الطويل - :
( لئن كانَ ذنبي أنَّ أحسنَ مَطْلبي ... أساءَ ففي سُوءِ القَضاءِ ليَ العذرُ )
مع قول البحتري - البسيط - :
( إِذا محاسنيَ اللاتي أدلُّ بها ... كانتْ ذُنوبي فقلْ لي : كيف أَعتَذِرُ )
وقول أبي تمام - البسيط - :
( قد يقدِمُ العَيْرُ من ذُعْرٍ على الأَسَدِ ... )
مع قولِ البحتري - الطويل - :
( فجاءَ مجيءَ العَيْر قادتْه حيرَةٌ ... إِلى أَهْرَتِ الشِّدْقَين تَدْمَى أظافِرُه )
وقولُ معنِ بن أوس - الطويل - :
( إِذا انصرفتْ نفسي عَنِ الشيءِ لم تكدْ ... إليه بوجهٍ آخرَ الدهرِ تُقْبِلُ )
( مع قولِ العباسِ بن الأحنف - البسيط - :
( نَقْلُ الجبالِ الرَّواسي مِنْ أماكِنها ... أخفُّ من ردِّ قلبٍ حينَ يَنْصرفُ )
وقولُ أمية بن أبي الصلت - الطويل - :
( عطاؤُكَ زَيْنٌ لامرىءٍ إِنْ أصبتَهُ ... بخَيْرٍ وما كلُّ العطاءِ يَزينُ ! )
مع قولِ أبي تمام - البسيط - :
( تُدْعى عطاياه وَفْراً وهْيَ إِنْ شُهرتْ ... كانتْ فَخاراً لمن يَعْفوهُ مؤْتَنِفا )
( ما زلتُ منتظراً أعجوبةً عَنَنَاً ... حَتى رأيتُ سُؤالاً يُجْتَنى شَرَفا )
وقولُ جَرير - الطويل - :
( بَعَثْنَ الهوَى ثمَّ ارتَمَيْنَ قلوبَنا ... بأسْهُمِ أعداءٍ وهنَّ صديقُ )
مع قولِ أبي نواس - الطويل - :
( إِذا امتحَنَ الدُّنيا لبيبٌ تكشَّفَتْ ... له عن عدوٍّ في ثيابِ صَديقِ )
وقولُ كثير - الطويل - :
( إِذا ما أرادتْ خُلَّةٌ أَن تُزيلَنا ... أبَيْنا وقُلنا : الحاجِبِيَّةُ أَوّلُ )
مع قولِ أبي تمام - الكامل - :
( نَقِّلْ فؤادَك حيثُ شئتَ مِنَ الهوى ما الحبُّ إِلاّ للحَبيبِ الأَوّلِ )
وقولُ المتنبي - الطويل - :
( وعِنْدَ مَنِ اليومَ الوفاءُ لصاحبٍ ... شَبيبٌ وأَوْفَى من تَرى أخَوانِ )
مع قولِ أَبي تمام - الطويل - :
( فلا تَحْسَبا هنداً لها الغدْرُ وحدَها ... سَجيّةُ نَفْسٍ كلُّ غانيةٍ هندُ )
وقولُ البحتري - الطويل - :
( ولم أرَ في رَنْقِ الصِّرَى ليَ مورداً ... فَحاولتُ وِرْدُ النِّيلِ عندَ احتفالِه )
مع قولِ المتنبي - الطويل - :
( قواصدَ كافورٍ تَواركُ غيرِه ... ومَنْ قصدَ البحرَ استقلَّ السَّواقيا )
وقول المتنبي من المنسرح :
( كأنَّما يُولَدُ النَّدى مَعَهمْ ... لا صِغَرٌ عاذِرٌ ولا هَرَمُ )
مع قولِ البحتري - الطويل - :
( عَريقونَ في الإِفضالِ يؤْتَنَفُ النَّدى ... لناشِئِهِم من حيثُ يُؤْتَنَفُ العُمْرُ )
وقولُ البحتري - الطويل - :
( فلا تُغلِيَنْ بالسَّيفِ كلَّ غلائِه ... ليَمضي فإِنَّ الكَفَّ لا السَّيفَ تَقْطَعُ )
مع قول المتنبي من - الطويل - :
( إِذا الهندُ سَوَّتْ بينَ سَيْفَيْ كريهةٍ ... فسيفُك في كَفٍّ تُزيلُ التَّساويا )
وقولُ البحتري - الكامل - :
( سامَوْكَ من حَسَدٍ فأفضلَ منهمُ ... غيرُ الجوادِ وجادَ غيرُ المُفْضِلِ )
( فبذلْتَ فينا ما بذلتَ سَماحةً ... وتكرُّماً وبذلتَ ما لم يُبْذَلِ )
مع قول أبي تمام - الطويل - :
( أرى الناسَ مِنهاجَ النَّدى بعدَما عَفَتْ ... مَهايعُهُ المُثْلى ومَحَّتْ لواحِبُهْ )
( ففي كلِّ نَجْد في البلادِ وغائرٍ ... مَواهِبُ ليستْ منه وهْيَ مواهبُهْ )
وقول المتنبي - البسيط - :
( بيضاءُ تُطمِعُ فيما تحتَ حُلَّتها ... وعزَّ ذلكَ مَطْلوباً إِذا طُلِبا )
مع قول البحتري - الكامل - :
( تَبْدو بِعَطفةِ مُطْمِعٍ حتّى إِذا ... شُغِلَ الخَليُّ ثَنَتْ بصَدْفةِ مُؤْيسِ ) وقولُ المتنبي - الكامل - :
( إِذْكارُ مِثلِكَ تَركُ إِذكاري لهُ ... إذْ لا تريدُ لِما أريدُ مُتَرجِما )
مع قولِ أبي تمام - الخفيف - :
( وإِذا المجدُ كانَ عَوْني عل المرءِ ... تقاضَيْتُهُ بتَرْكِ التَّقاضي )
وقولُ أبي تمام - الكامل - :
( فَنَعمتُ مِن شَمْسٍ إِذا حُجِبَتْ بَدَتْ ... من خِدرِها فكأَنَّها لم تُحجَبِ )
مع قولِ قيس بن الخطيم من المنسرح :
( قضى لها اللهُ حِينَ صوَّرها الخالقُ ... ألاَّ يُكِنَّها سَدَفُ )
وقولُ المتنبي - الخفيف - :
( رامياتٍ بأسْهُمٍ ريشُها الهُدْبُ ... تشُقُّ القلوبَ قبلَ الجلودِ )
مع قولِ كثير - الطويل - :
( رَمَتْني بسهمٍ ريشُهُ كالكحلُ لم يَجُزْ ... ظواهرَ جِلدي وهْوَ في القلبِ جارحُ )
وقولُ بعض شعراء الجاهلية ويُعْزَى إِلى لبيد - الكامل - :
( ودَعوتُ ربِّي بالسَّلامةِ جاهداً ... لِيُصحَّني فإِذا السَّلامةُ داءُ )
مع قولِ أبي العتاهية - الرجز - :
( أسرَعَ في نَقْصِ امرىءٍ تمامُهُ ... تُدْبرُ في إِقبالها أيَّامُهُ )
وقولُه - مجزوء الكامل - :
( أَقْلِلْ زيارَتَكَ الحبيبَ ... تكونَُ كالثَّوْبِ استجَدَّهْ )
( إِنَّ الصَّديقَ يُمِلُّهُ ... أَنْ لا يزالَ يَراكَ عِنْدَهْ )
مع قولِ أبي تمام - الطويل - :
( وطولُ مُقام المرءِ في الحيِّ مُخلِقٌ ... لِديباجَتَيْهِ فاغترِبْ تَتَجدَّدِ )
وقولُ الخريميّ - الرمل - :
( زادَ معروفَكَ عندي عِظَماً ... أَنَّه عندكَ محقورٌ صغيرُ )
( تَتَناساهُ كأنْ لم تأتِهِ ... وهْوَ عِنْدَ الناسِ مشهورٌ كبيرُ )
مع قولِ المتنبي - المنسرح - :
( تظنُّ مِن فقْدِكَ اعتدادَهُمُ ... أنَّهُم أَنعَموا وما عَلِموا )
وقولُ البحتري - الوافر - :
( ألمْ تَرَ للنَّوائبِ كيفَ تَسمُو ... إِلى أهلِ النَّوافلِ والفُضُولِ )
مع قولِ المتنبي - البسيط - :
( أفاضِلُ الناس أغراضٌ لذا الزَّمنِ ... يَخلو منَ الهمِّ أخلاهُمْ منَ الفِطَنِ )
وقولُ المتنبي - الطويل - :
( تذلَّلْ لها واخضَعْ على القرْبِ والنَّوَى ... فما عاشقٌ مَن لا يَذِلُّ ويَخْضَعُ )
مع قولِ بعض المحدثين - مجزوء الرمل - :
( كنْ إِذا أحببتَ عَبداً ... للذي تَهْوى مُطيعا )
( لن تنالَ الوصْلَ حتّى ... تُلزِمَ النَّفْسَ الخُضوعا )
وقولُ مضرِّسِ بن ربْعيّ - الطويل - :
( لَعَمرُك إِنِّي بالخليل الذي له ... عليَّ دلالٌ واجبٌ لمفجَّعُ )
( وإِنِّي بالمَولى الذي لَيس نافعي ... ولا ضَائري فُقْدانُهُ لَمُمَتَّعُ )
مع قولِ المتنبي - الطويل - :
( أَمَا تغلطُ الأيامُ فيَّ بأنْ أرى ... بَغيضاً ثُنائي أو حبيباً تُقرِّبُ )
وقولُ المتنبي - البسيط - :
( مظلومةُ القَدِّ في تشبيههِ غُصناً ... مظلومةُ الرِّيقِ في تَشبيهه ضَرَبا )
مع قولِه - الطويل - :
( إِذا نحنُ شَبَّهناكَ بالبدر طالعاً ... بَخَسناك حَظاً أنتَ أبهى وأجملُ )
( ونَظلمُ إِنْ قِسْناك باللَّيث في الوغَى ... لأنَّك أحمَى للحريمِ وأبسَلُ )
القسم الثاني
ذكرُ ما أنتَ ترى فيه في كلِّ واحدٍ من البيتين صنعةً وتصويراً وأستاذيةً على الجملة فمن ذلك وهو مِنَ النادر قولُ لبيد من الرمل :
( واكذِبِ النَّفْسَ إِذا حدَّثْتَها ... إِنَّ صِدقَ النَّفسِ يُزري بالأملْ )
مع قولِ نافعِ بن لَقيط - الكامل - :
( وإِذا صدقْتَ النفسَ لم تترُكْ لها ... أملاً ويأمَلُ ما اشْتَهى المَكْذوبُ )
وقولُ رجلٍ من الخوارج أُتِيَ به الحجاج في جماعةٍ من أصحاب قَطَرِيٍّ فقتلَهم ومَنَّ عليه ليدٍ كانت عندَه وعاد إِلى قَطَرِيٍّ فقال له قَطَريٌّ : عاوِدْ قتالَ عدوِّ الله الحجاج فأبى وقال - الكامل - :
( أأقاتِلُ الحَجَّاجَ عن سُلطانِه ... بيدٍ تُقِرُّ بأنَّها مَولاتُه )
( ماذا أقُولُ إِذا وقَفْتُ إِزاؤَهُ ... في الصَّفِّ واحتجَّتْ لَهُ فَعَلاتُهُ )
( وتحدَّثَ الأقْوامُ أنَّ صنَائعاً ... غُرِسَتْ لَدَيَّ فَحَنْظَلَتْ نخلاتُهُ )
مع قولِ أبي تمام - الطويل - :
( أُسَرْبِلُ هُجْرَ القَوْلِ مَن لو هَجَوتُهُ ... إِذاً لهَجاني عنهُ مَعْرُوفهُ عِنْدِي )
وقولُ النّابغة - الطويل - :
( إِذا ما غَدا بالجَيْش حلَّقَ فوقَهُ ... عصائِبُ طَيْرٍ تَهْتَدي بعصائبِ )
( جوانحَ قَدْ أيقنَّ أنّ قَبيلَهُ ... إِذا ما التَقى الصَّفَّان أَوّل غالِبِ )
مع قولِ أَبي نواس - مجزوء الرمل - :
( وإِذا مَجَّ القَنا عَلقاً ... وتراءى الموتُ في صُوَرِهْ )
( راحَ في ثِنْيَيْ مُفاضَتهِ ... أسَدٌ يَدْمَى شَبا ظُفُرِهْ )
( تَتأيّا الطَّيْرُ غُدْوَتَهُ ... ثِقَةً بالشِّبعِ من جَزرِهْ )
المقصودُ البيتُ الأخيرُ . وحكى المَرْزُبانيُّ قال : حدَّثني عمرٌو الورَّاقُ :
رأيتُ أبا نواس يُنْشِد قصيدتَه التي أولها :
( أَيُّها المُنتابُ عَنْ عُفُرِهْ ... )
فحسدتهُ . فلم بلغَ إِلى قوله :
( تَتأيّا الطَّيرُ غُدْوَتَهُ ... ثِقةً بالشِّبْعِ مِن جَزَرِهْ )
قلتُ له : ما تركتَ للنابغة شيئاً حيثُ يقول : إِذا ما غدا بالجيش : البيتين - فقال : اسكتْ فلئن كان سَبقَ فما أسأتُ الاتّباع
وهذا الكلامُ من أبي نواسٍ دليلٌ بيِّنٌ في أن المعنى يُنْقلُ من صورةٍ إِلى صورة . ذاك لأنه لو كان لا يكونُ قد صَنَعَ بالمعنى شيئاً لكانَ قوله : فما أسأتُ الاتّباعَ : مُحالا . لأنّه على كل حال لم يَتَّبعه في اللفظ . ثم إِن الأَمْرَ ظاهرٌ لمن نَظَرَ في أنه قد نقل المعنى عن صورته التي هو عليها في شِعْر النابغَة إِلى صورةٍ أخرى وذلك أن هاهنا معنيين : أحدُهما أصلٌ
وهو علمُ الطَّير بأنَّ الممدوحَ إِذا غزا عدوّاً كان الظَفَرُ له وكان هو الغالبَ . والآخرُ فرعٌ وهو طَمعُ الطَّيْر في أن تتَّسع عليها المطاعمُ من لُحوم القَتلى . وقد عمد النابغةُ إِلى الأصل الذي هو علمُ الطير بأنَّ الممدوح يكون الغالبَ فذَكَره صريحاً وكَشَفَ عن وجهه . واعتمد في الفرع الذي هو طمعُها في لحوم القتلى . وإِنها لذلك تحلِّقُ فوقه على دلالةِ الفحوى . وعكسَ أبو نواس القِصَّةَ فذكر الفرعَ الذي هو طمعُها في لحوم القتلى صريحاً فقال كما ترى :
( ثقةً بالشِّبعِ مِنْ جَزَرِهْ ... )
وعوَّلَ في الأصل الذي هو علمُها بأنَّ الظفرَ يكونُ للممدوح على الفحوى ودلالة الفحوى على علمها أنَّ الظفرَ يكونُ للممدوح هي في أن قال : " من جَزَرِه " . وهي لا تثِقُ بأن شبعَها يكون منجَزَرِ الممدوح حتى تعلمَ أنَّ الظفرَ يكون له . أفيكونُ شيءٌ أظهرَ من هذا في النقلِ عن صورةٍ إِلى صورة
( أرجعُ إِلى النَسَقِ . ومن ذلك قولُ أبي العتاهية - الخفيف - :
( شِيَمٌ فَتَّحَتْ من المَدْحِ ما قد ... كان مستغلِقاً على المُدَّاحِ )
مع قولِ أبي تمام - الكامل - :
( نظمتْ له خَرَزَ المديح مواهبٌ ... ينفُثْن في عُقَدِ اللسانِ المُفْحَمِ )
وقول أبي وجزة - الوافر - :
( أتاك المجدُ من هَنَّا وَهَنّا ... وكنتَ له كمجتمَعِ السُّيولِ )
مع قولِ منصور النَّمري - البسيط - :
( إِنَّ المكارمَ والمعروفَ أوديةٌ ... أحلَّكَ اللهُ منها حيثُ تَجْتمعُ )
وقولُ بشَّار - البسيط - :
( الشّيبُ كُرهٌ وكُرْهٌ أنْ يفارِقَني ... أعْجبْ بشيءٍ على البغضاءِ مَوْدودِ )
مع قولِ البحتري - الوافر - :
( تعيبُ الغانياتُ عليَّ شَيبي ... ومَنْ لي أن أمتَّعَ بالمَعيبِ )
وقول أبي تمام - الوافر - :
( يشتاقُهُ من كمالِه غدُهُ ... ويُكثر الوجدَ نحوهُ الأمسُ )
مع قول ابن الرومي - الطويل - :
( إِمامٌ يظَلُّ الأمسُ يُعمِلُ نحوَهُ ... تَلَفُّتَ مَلْهُوفٍ ويشتاقُهُ الغَدُ )
لا تنظرْ إِلى أنه قال : " يشتاقه الغدُ " فأعاد لفظَ أبي تمام ولكنَّ النظرَ إِلى قوله : يُعملُ نحوَهُ تلفُّتَ مَلهوف
وقولُ أبي تمام - الطويل - :
( لئن ذَمَّتِ الأَعداءُ سُوءَ صبَاحِها ... فليسَ يُؤدِّي شُكرَها الذِّئبُ والنَّسْرُ )
مع قول المتنبي - المتقارب - :
( وأنْبتَّ منهم ربيعَ السّباعِ ... فأثنَتْ بإِحْسانِكَ الشَّاملِ )
وقولُ أبي تمام - البسيط - :
( ورُبَّ نائي المَغاني رُوحُهُ أبداً ... لصيقُ رُوحي ودَانٍ ليسَ بالدَّاني )
مع قولِ المتنبي - الوافر -
( لنا ولأهْلِه أبَداً قلوبٌ ... تَلاقى في جُسومٍ ما تَلاقى )
وقولُ أبي هِفَّان - الرمل - :
( أصبحَ الدَّهرُ مُسيئاً كلُّهُ ... ما لَهُ إِلاّ ابنَ يحيى حَسَنهْ )
مع قولِ المتنبي - الطويل - :
( أزالتْ بكَ الأيّامُ عتَبْي كأنّما ... بنوها لها ذَنبٌ وأنْتَ لَها عذرُ )
وقولُ علي بنِ جَبَلة - الكامل - :
( وأرى الليالي ما طَوَتْ من قُوَّتي ... رَدَّتْه في عِظَتي وفي إِفهامي )
مع قولِ ابن المعتزّ - المتقارب - :
( وما يُنتقصْ من شَبابِ الرِّجالِ ... يزِدْ في نُهاها وألبابِها )
وقولُ بَكْرِ بن النَّطَّاح - الطويل - :
( ولو لم يكنْ في كفِّهِ غيرُ روحِه ... لجادَ بها فليتَّقِ اللهَ سائِلُهْ )
مع قول المتنبي - المنسرح - :
( إِنكَ من معشرٍ إِذا وَهَبوا ... ما دونَ أعمارِهِمْ فقد بَخِلوا )
وقولُ البحتري - الطويل - :
( ومنْ ذَا يلومُ البحرَ أَنْ باتَ زاخراً ... يفيضُ وصوبَ المُزنِ أَنْ راحَ يَهْطِلُ )
مع قول المتنبي - البسيط - :
( وما ثناكَ كلامُ الناسِ عن كَرَمٍ ... ومن يسُدُّ طريقَ العارضِ الهَطِلِ )
وقولُ الكندي - الكامل - :
( عَزُّوا وعَزَّ بعزِّهِم مَنْ جاوَرُوا ... فَهُمُ الذُّرى وجَماجِمُ الهاماتِ )
( إِنْ يَطلبُوا بِتراتِهِمْ يُعطَوْا بها ... أو يُطْلَبُوا لا يُدْرَكوا بِتراتِ )
مع قولِ المتنبي - الطويل - :
( تُفيتُ الليالي كلَّ شيءٍ أخذْتَهُ ... وهُنَّ لِما يأخُذْنَ منكَ غَوارمُ )
وقولُ أبي تمام - الطويل - :
( إِذا سيفُهُ أضحى على الهامِ حاكِماً ... غَدا العفْوُ منهُ وهْوَ في السَّيْفِ حاكمُ )
مع قولِ المتنبي - الكامل - :
( لهُ من كَريمِ الطَّبْع في الحَرْبِ مُنْتَضٍ ... ومِنْ عادَةِ الإِحسانِ والصَّفْحِ غامِدُ )
فانظُرِ الآن نظرَ مَن نفى الغفلةَ عن نفسه فإِنكَ ترى عياناً أنَّ للمعنى في كل واحدٍ من البيتين مِنْ جميعِ ذلك صورةً وصفةً غيرَ صورتِه وصفتِه في البيتِ الآخر . وأَنَّ العلماءَ لم يريدوا حيثُ قالوا : إِنَّ المعنى في هذا هو المعنى في ذاك أنَّ الذي تعقِلُ من هذا لا يخالفُ الذي تَعقِلُ من ذاك . وأنَّ المعنى عائدٌ عليك في البيتِ الثاني على هيئتِه وصفتِه التي كانَ عليها في البيتِ الأوّل وأنْ لا فرقَ ولا فصلَ ولا تبايُنَ بوجهٍ من الوجوه وأنَّ حكمَ البيتين مثلاً حكمُ الاسمينِ قد وُضعا في اللغة لشيءٍ واحدٍ كالليث والأسد . ولكن قالوا ذلك على حَسَب ما يقولُه العقلاء في الشيئين يجمعهما جنسٌ واحد ثم يفترقان بخواصَ ومزايا وصفاتٍ كالخاتم والخاتم والشنفِ والشنفِ والسّوارِ والسّوار وسائر أصناف الحُليِّ التي يجمعُها جنسٌ واحد ثم يكون بينها الاختلافُ الشّديدُ في الصنعة والعمل
ومَنْ هذا الذي ينظر إِلى بيتِ الخارجيِّ وبيتِ أبي تمام فلا يعلم أن صورةَ المعنى في ذلك غيرُ صورته في هذا كيف والخارجيُّ يقول : واحتجَّت له فعلاته . ويقول أبو تمام :
( إذًا لَهجاني عنْه مَعْروفُه عندي ... )
ومتى كان احتجَّ وهَجا واحداً في المعنى وكذلك الحكمُ في جميع ما ذكرناه فليسَ يتصوَّر في نفسِ عاقلٍ أنْ يكونَ قولُ البحتري :
( وأحَبُّ آفاقِ البلاد إِلى الفَتى ... أرْضٌ ينالُ بها كَريمَ المَطْلَبِ )
وقولُ المتنبي :
( وكلُّ مكان ينبتُ العِزّ طَيِّبُ ... )
سواء
واعلمْ أنَّ قولنا : الصورةُ إِنما هو تمثيلٌ وقياس لما نَعْلَمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا . فلما رأينا البينونةَ بين آحادِ الأجناسِ تكونُ من جهة الصورةِ فكان بيْنُ إِنسانٍ
مِنْ إِنسان وفرس من فرس بخصوصيةٍ تكونُ في صورةِ هذا لا تكونُ في صورةِ ذاك
وكذلك كان الأمرُ في المصنوعاتِ فكانَ تَبَيُّنُ خاتِم من خاتِمٍ وسِوارٍ من سِوارٍ بذلك . ثم وَجَدْنا بينَ المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونةً في عقولنا وفرقاً عبَّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قُلنا : " للمعنى في هذا صورةٌ غيرُ صورته في ذلك " . وليس العبارةُ عن ذلك بالصورةِ شيئاً نحن ابتدأناه فينكِرُه منكِرٌ بل هو مستَعْملٌ مشهورٌ في كلام العلماء . ويكفيك قولُ الجاحظِ : " وإِنما الشعر صناعةٌ وضربٌ من التصوير "
واعلمْ أنه لو كانَ المعنى في أحد البيتين يكونُ على هيئته وصفتِه في البيتِ الآخر وكانَ التالي من الشاعِرَيْن يجيئك به مُعاداً على وجهه لم يُحدِثْ فيه شيئاً ولم يغيرْ له صفةً لكان قولُ العلماءِ في شاعرٍ : إِنه أَخَذَ المعنى مِنْ صاحِبِه فأحسنَ وأجادَ . وفي آخَر : إِنه أساء وقصَّر لغواً من القولِ من حيثُ كان مُحالاً أنْ يحسنَ أو يسيءَ في شيءٍ لا يصنع به شيئاً . وكذلك كانَ يكون جعلُهم البيتَ نظيراً للبيت ومناسباً له خطأ منهم لأنه محالٌ أن يناسِبَ الشيءُ نفسَه وأن يكونَ نظيراً لنفسِه . وأمرٌ ثالث وهو أنهم يقولون في واحد : " إِنه أخَذَ المعنى فظهر أخذُه وفي آخر : إِنه أخذَه فأخفَى أخذه . ولو كان المعنى يكونُ مُعاداً على صورتِه وهيئتِه وكانَ الآخِذُ له مِنْ صاحِبِهِ لا يصنَعُ شيئاً غيرَ أن يبْدِلَ لفظاً مكانَ لفظ لكان الإخفاءُ فيه محالاً لأن اللفظ لا يُخفى المعنى وإنما يُخْفيه إِخراجُه في صورةٍ غيرِ التي كانَ عليها . مثالُ ذلك أن القاضي أبا الحَسَن ذكر فيما ذكر فيه تناسُبَ المعاني بيتَ أبي نواس - مجزوء الرمل - :
( حَلِيَتْ والحُسْنُ تأخذُهُ ... تَنْتَقِي منهُ وتنتخِبُ )
وبيتَ عبدِ الله بنِ مُصْعَب - الوافر - :
كأنَّك جئتَ محتكِماً عليهمْ ... تخَيَّرُ في الأبُوَّةِ ما تشاءُ )
وذكر أنهما معاً من بيتِ بشَّار - الطويل - :
( خُلِقتُ على ما فيَّ غيرَ مُخيَّرٍ ... هَوايَولو خُيِّرتُ كنتُ المهذَّبا )
والأمرُ في تناسب هذه الثلاثةِ ظاهرٌ . ثم إنه ذكر أن أبا تمام قد تناوله فأخفاهُ وقال - الوافر - :
( فلَوْ صَوَّرْتَ نفسَكَ لم تَزِدْها ... على ما فيكَ من كَرَمِ الطِّباعِ )
ومن العَجَبِ في ذلك ما تراه إِذا أنتَ تأمّلْت قولَ أبي العتاهية - الكامل - :
( جُزِيَ البخيلُ عليَّ صالِحة ... عنّي لخفّتِهِ على ظَهْري )
( أَعلى وأكرمَ عن يَدَيْهِ يَدي ... فَعَلَتْ ونَزَّه قدْرُه قَدْري )
( ورُزقْتُ من جَدواهُ عافيةً ... أنْ لا يضيقَ بشُكرِه صَدري )
( وغَنِيتُ خِلْواً مِن تَفَضُّله ... أحْنُو عَليه بأحْسَنِ العُذْرِ )
( ما فاتَني خَيْرُ امرىءٍ وضَعتْ ... عَنّي يَداهُ مؤونةَ الشُّكْرِ )
ثم نظرتَ إِلى قولِ الذي يقول - المنسرح - :
( أعتقني سوءُ ما صنعتْ من الرْرِقِّ ... فيا برْدَها على كَبِدي )
( فصرتُ عَبْداً للسُّوءِ فيك وما ... أحْسَنَ سُوءاً قَبلي إِلى أَحَدِ )
وممَّا هو في غاية النُّدْرة من هذا الباب ما صَنَعه الجاحظُ بقولِ نُصيبٍ - الطويل - :
( ولو سَكتوا أَثْنَتْ عليكَ الحقائبُ ... )
حين نثرَهُ فقال : وكتب به إِلى ابن الزّيات : نحن أعزَّك الله نَسْحَرُ بالبيان ونموِّهُ بالقول . والناسُ ينظرون إِلى الحالِ ويَقْضون بالعيانِ . فأثِّرْ في أمرنا أثراً ينطِقُ إِذا سَكَتنا فإِن المدَّعي بغيرِ بينةٍ متعرِّضٌ للتكذيب
وهذه جملةٌ من وصفِهم للشعرِ وعملِه وإِدلالهم به :
أبو حَيّة النُّمَرْي - الكامل - :
( إِنَّ القصائدَ قد عَلِمْنَ بأنَّني ... صَنَعُ اللّسانِ بهنَّ لا أتنَحَّلُ )
( وإِذا ابْتَدأتُ عَرُوض نَسْجٍ ريّضٍ ... جَعَلَتْ تَذِلُّ لِما أُريدُ وتُسْهِلُ )
( حتّى تطاوِعَني ولو يَرْتَاضُها ... غَيْري لحَاوَلَ صَعْبَةً لا تقبِلُ )
تميمُ بنُ مُقْبل - الطويل - :
( إِذا مِتُّ عن ذِكْر القوافي فلَنْ تَرى ... لها قائلاً بَعْدِي أَطَبَّ وأشعَرا )
( وأكثرَ بَيْتاً سائراً ضُرِبَتْ له ... حُزونُ جبالِ الشِّعرِ حتَّى تَيَسَّرا )
( أغَرَّ غريباً يَمسَحُ النّاسُ وَجْهَهُ ... كما تَمْسَحُ الأيدي الأَغَرَّ المُشهَّرا )
عَديُّ بنُ الرِّقاع - الكامل - :
( وقَصيدةٍ قد بِتُّ أجْمَعُ بَيْنَها ... حَتَّى أُقوِّمَ مَيْلَها وسِنادَها )
( نَظَرَ المثقِّفِ في كُعُوبِ قَناتِه ... حتَّى يُقيمَ ثِقافُهُ مُنْآدَها )
كَعْبُ بن زهير - الطويل - :
( فَمَنْ للقوافي شانَها مَن يَحوكُها ... إِذا ما ثَوى كعْبٌ وفوَّزَ جَرْوَلُ )
( يقوِّمُها حَتَّى تَلِينَ متُونُها ... فَيقصُرُ عَنْهَا كُلُّ ما يُتمثَّلُ )
بشَّار - الطويل - :
( عَمِيتُ جنيناً والذَّكاءُ منَ العَمَى ... فجِئتُ عجيبَ الظَنِّ للعِلم موئلا )
( وغاضَ ضياءُ العينِ للعلمِ رافداً ... لقلبٍ إِذا ما ضيَّع الناسُ حَصَّلا )
( وشِعرٍ كَنَوْرِ الرَّوْضِ لاءَمْتُ بَيْنَهُ ... بقولٍ إِذا ما أحزَنَ الشِّعرُ أَسْهلا )
وله - المنسرح - :
( زَوْرُ ملوكٍ عليه أبَّهةٌ ... يُغرَف من شعرِه ومن خُطَبِهْ )
( للهِ ما راحَ في جوانِحِهِ ... مِنْ لؤلؤٍ لا يُنامُ عَنْ طلبِهْ ) ( يخرجُ مِنْ فيه للنَّدِيِّ كما ... يَخْرُجُ ضَوءُ النَّهارِ من لَهَبِهْ )
أبو شريح العُمَير - الوافر - :
( فإِنْ أهلِكْ فقد أبقيتُ بَعْدي ... قَوافيَ تُعجبُ المُتَمَثِّلينا )
( لذيذاتِ المقاطعِ مُحكماتٍ ... لوَ أنَّ الشِّعْرَ يُلْبَسُ لارتُدينا )
الفرزدق - الوافر - :
( بَلغْنَ الشمسَ حين تكونُ شَرقاً ... ومَسقَطَ قَرنِها من حيثُ غابا )
( بكلِّ ثَنِيَّة وبكلِّ ثَغْرٍ ... غرائبُهُنَّ تنتسبُ أنْتِسابا )
ابن مَيَّادة من - الطويل - :
( فَجَرْنا ينابيعَ الكلامِ وبَحْرَهُ ... فأصبحَ فيهِ ذو الرِّوايةِ يَسْبحُ )
( وما الشِّعر إِلاّ شعرُ قيسٍ وخِنْدِفٍ ... وشعرُ سِواهُمْ كُلْفةٌ وتملُّحُ )
وقال عقالُ بنُ هاشم القَينيُّ يردُّ عليه - الطويل - :
( ألا بلِّغِ الرَّمَّاحَ نقْضَ مقالةٍ ... بها خَطِلَ الرَّمَّاحُ أو كان يَمزَحُ )
( لئن كان في قيسٍ وخِنْدِفَ ألسُنٌ ... طِوالٌ وشِعرٌ سائرٌ ليس يُقْدَحُ )
( لقد خَرَّقَ الحيُّ اليمانون قبلَهُمْ ... بحورَ الكلام تُسْتَقَى وهْيَ طُفَّحُ )
( وهُمْ عَلَّموا مَنْ بَعْدَهُم فتعلَّموا ... وهمْ أَعربوا هذا الكلامَ وأَوْضَحوا )
( فللسَّابقينَ الفَضْلُ لا تَجْحَدونه ... وليس لِمَسْبُوقٍ عليهم تَبجُّحُ )
أبو تمام - الطويل - :
( كشفْتُ قِناعَ الشِّعرِ عن حُرِّ وجههِ ... وطيِّرتُه عن وَكرِهِ وهْوَ واقعُ )
( بِغُرٍّ يراها مَن يراها بسَمْعِهِ ... ويدنو إِليها ذو الحِجا وهْوَ شاسِعُ )
( يَودُّ وِداداً أنّ أعضاءَ جسمِهِ ... إِذا أُنشِدَتْ شَوقاً إِليها مَسامعُ )
وله - الكامل - :
( حذّاءَ تملأ كلَّ أذْنٍ حكمةً ... وبلاغةً وتُدِرُّ كلَّ وريدِ )
( كالدُّرِّ والمَرْجانِ أُلِّفَ نظمُهُ ... بالشَّذْرِ في عُنقِ الفتاةِ الرُّودِ )
( كَشقيقةِ البُرْدِ المُنَمنَمِ وشيُهُ ... في أرضِ مَهْرةَ أو بلادِ تَزِيدِ )
( يُعطي بها البُشْرى الكريمُ ويَرتدي ... بردائِها في المَحفِلِ المَشْهودِ ) ( بُشْرى الغَنيِّ أبي البناتِ تتابعتْ ... بُشراؤهُ بالفارسِ المَولودِ )
وله - الكامل - :
( جاءتك مِنْ نَظمِ اللسانِ قلادةٌ ... سِمْطانِ فيها اللؤلؤُ المَكْنونُ )
( أحْذَاكَها صَنَعُ الضَّميرِ يَمُدُّه ... جَفْرٌ إِذا نَضَبَ الكلامُ مَعينُ )
أخذ لفظ الصَّنعَ من قول أبي حَيّة : " بأنّني صَنعُ اللسان بهنَّ لا أتنحَّلُ " ونقله إِلى
الضمير . وقد جعل حسان أيضاً اللسانَ صَنعاً وذلك في قوله - البسيط - :
( أهْدَى لهم مِدَحاً قَلبٌ مُؤازِرُهُ ... فيما أحبَّ لسَانٌ حائكٌ صَنَعُ )
ولأبي تمام من - الطويل - :
( إِليكَ أرَحنا عازِبَ الشعرِ بعدَما ... تمهَلَ في رَوْضِ المعاني العجائبِ )
( غرائبُ لاقَتْ في فِنائكَ أنسَها ... مِنَ المَجْدِ فهْيَ الآنَ غيرُ غرائبِ )
( ولو كان يَفنى الشِّعرُ أفناهُ ما قَرَتْ
... حِياضُكَ منهُ في السّنين الذَّواهِبِ )
( ولكنّهُ صَوْبُ العقولِ إِذا انْجلتْ ... سَحائبُ منه أُعْقِبَتْ بِسَحائبِ )
البحتري - الطويل - :
( ألستُ المُوالِي فيك نظمَ قصائدٍ ... هي الأنجمُ اقتَادتْ معَ الليل أنْجُما )
( ثناءٌ كأَنَّ الروضَ منهُ مُنوِّراً ... ضُحًى وكأَنَّ الوشْيَ منه مُنَمْنما )
وله - البسيط - :
( أحسِنْ أبا حسنٍ بالشِّعر إذْ جُعلَتْ ... عليكَ أنجمُهُ بالمَدْحِ تَنْتَثِرُ )
( فَقَدْ أتَتْكَ القَوافِي غَبَّ فائدةٍ ... كما تَفَتَّحَ غِبَّ الوابلِ الزَّهَرُ )
وله - الطويل - :
( إليكَ القوافي نازعاتٌ قواصدُ ... يُسَيِّرُ ضاحِي وَشْيِها وَيُنَمنِمُ )
( ومُشرِقةٌ في النظمِ غرٌّ يَزِينُها ... بهاءً وحُسناً أنها لك تُنظمُ )
وله - الطويل - :
( بِمَنْقوشَةٍ نَقْشَ الدَّنانيرِ يُنْتَقى ... لها اللَّفظُ مُختاراً كما يُنتقَى التِّبْرُ )
وله - الطويل - :
( أيذهبُ هذا الدَّهرُ لم يَرَ مَوْضِعي ... ولم يَدْرِ ما مقدارُ حَلِّي ولا عَقْدي )
( ويَكْسَدُ مِثْلي وهْو تاجرُ سُؤْدَدٍ ... يبيعُ ثَميناتِ المَكارمِ والمجدِ )
سَوائرُ شِعْرٍ جامعٍ بَدَدَ العُلى ... تَعَلَّقْنَ مَنْ قَبلي وأَتْعَبنَ مَنْ بَعدي )
( يُقَدِّرُ فيها صانعٌ متعمِّلٌ ... لإِحكامِها تقديرَ دَاودَ في السَّرْدِ )
وله - الكامل - :
( اللهُ يسهرُ في مديحكَ ليلَهُ ... مُتَمَلمِلاً وتنامُ دونَ ثوابهِ )
( يقظانُ ينتحِلُ الكلامَ كأنَّه ... جيشٌ لديهِ يريدُ أن يُلْقَى بهِ )
( فأتَى به كالسّيفِ رقرَقَ صيقَلٌ ... ما بينَ قائمِ سِنْخِه وذُبابِه )
ومن نادر وصفه للبلاغة قوله - الخفيف - :
( في نظامٍ منَ البلاغةِ ما شَكْكَ ... امْرؤٌ أنَّه نِظامٌ فريدِ )
( وبديعٍ كأنَّه الزَّهرُ الضّاحكُ ... في رَوْنَقِ الرَّبيعِ الجديدِ )
( مشرقٌ في جوانبِ السَّمعِ ما يُخْلِقُهُ ... عَودُهُ على المُسْتعيدِ )
( حُجَجٌ تُخْرِسُ الألَدَّ بألفاظٍ ... فُرادى كالجَوهرِ المعدودِ )
( ومَعانٍ لو فَصَّلَتْها القَوافي ... هَجَّنَتْ شِعرَ جَروَلٍ ولَبيدِ )
( حُزْنَ مُستعمَلَ الكلامِ اخْتياراً ... وتجنَّبْنَ ظُلمَةَ التَّعقيدِ )
( ورَكبْنَ اللّفظَ القريبَ فأدركْنَ ... بهِ غايَةَ المُرادِ البَعيدِ )
( كالعَذَارَى غَدَوْنَ في الحُلَل الصُّفْرِ ... إِذا رُحْنَ في الخُطوطِ السودِ )
الغرضُ من كَتْبِ هذه الأبيات الاستظهارُحتى إِنْ حَمَل حامِلٌ نفسَه على الغَررِ والتقحُّم على غير بصيرةٍ فزعم أنَّ الإِعجازَ في مذَاقةِ الحروفِ وفي سلامَتِها مما يثقُلُ على اللسانِ علمَ بالنظرِ فيها فسادَ ظنِّه وقُبْحَ غَلطه من حيثُ يرى عياناً أنْ ليس كلامُهم كلاَمَ مَن خطر ذلك منه ببالٍ ولا صفاتُهم صفاتٍ تصلحُ له على حال إِذ لا يَخفى على عاقلٍ أنْ لم يكن ضربُ " تميم " لحزون جبال الشعر لأنْ تسلمَ ألفاظُه من حروفٍ تثقل على اللسان ولا كان تقويم " عديٍّ " لشعره ولا تشبيهُه نظرَه فيه بنظرِ المثقِّف في كُعوبِ قَناته ذلك وأَنه محالٌ أن يكونَ له جعل " بشار " نورَ العين قد غاض فصارَ إِلى قبله وأن يكون اللؤلؤُ الذي كان لا ينامُ عن طلبه وأنْ ليس هو صوبَ العقول الذي إِذا " انجلَتْ سَحائبُ منه أُعقبتْ بسحائب " وأنْ ليس هو " الدرَّ والمَرجان " مؤلفاً بالشَّذر في العقد ولا الذي له كان " البحتريُّ " مقدِّراً تقديرَ داود في السَّرد
كيف وهذه كلُّها عباراتٌ عما يُدْركُ بالعقل ويُسْتَنْبَط بالفكر وليس الفكرُ الطريقَ إِلى تمييز ما يثقُلُ على اللسان مما لا يَثْقُلُ إِنَّما الطريقُ إِلى ذلك الحس . ولولا أنَ البلوى قد عَظُمَتْ بهذا الرأي الفاسد وأن الذين قد استهلكوا فيه قد صاروا من فَرْط شَغفهم به يُصغُون إِلى كلِّ شيءٍ يسمَعونه . حتى لو أنَّ إِنساناً قال : " باقلَى حار " يريهِم أنه يريدُ نصرةَ مذهبِهم لأقبلوا بأوجههم عليه فألقوا أسماعَهم إِليه لكان اطِّراحُهُ وتركُ الاشتغال بهِ أصوبَ لأنّه قولٌ لا يتَّصلُ منه جانبٌ بالصّواب البتة
ذلك لأنَّه أولُ شيءٍ يؤدي إِلى أن يكونَ القرآنُ معجزاً لا بما بهِ كان قرآناً وكلامَ الله
عز و جل لأنّه على كلِّ حال إِنما كان قُرآناً وكلامَ الله عز و جل بالنَّظم الذي هو عَليه . ومعلومٌ أن ليس النظمُ من مذاقةِ الحُروف وسلامتها مما يَثْقُل على اللِّسان في شيء . ثم إِنه اتّفاقٌ منَ العقلاء أن الوصف الذي به تَنَاهى القرآنُ إِلى حَدٍّ عَجِزَ عنه المخلوقون هو الفصاحةُ والبلاغة . وما رأينا عاقلاً جعلَ القرآن فصيحاً أو بليغاً بأن لا يكونَ في حُروفهِ ما يثقلُ على اللّسان لأنه لو كان يصحُّ ذلك لكان يجبُ أن يكون السُّوقيُّ الساقطُ من الكلام والسَّفْسَافُ الرَّديءُ من الشعرِ فصيحاً إِذا خَفَّتْ حروفهُ . وأعجبُ من هذا أنهُ يَلْزَمُ منه أنه لو عَمد عامدٌ إلى حركاتِ الإِعراب فجعلَ مكانَ كلِّ ضمَّة وكسرةٍ فتحةً فقال : " الحمد لله " بفتح الدال واللام والهاء وجرى على هذا في القرآنِ كلِّه أن لا يسلبُه ذلك الوصفَ الذي هو مُعْجِزٌ به بل كان ينبغي أن يزيدَ فيه لأن الفتحةَ كما لا يخفى أخفُّ من كلِّ واحدةٍ من الضمة والكسرة . فإِنْ قال : إِن ذلك يحيلُ المعنى . قيلَ له : إِذا كان المعنى والعلةُ في كونه معجزاً خفةَ اللفظ وسهولته فينبغي أن يكون مع إحالة المعنى معجزاً . لأنه إِذا كان معجزَ الوصفِ يخصُّ لفظَه دون معناه كانَ محالاً أن يخرج عن كونهِ معجزاً مع قيام ذلك الوصف فيه
ودَعْ هذا وهَبْ أنه لا يلزمُ شيءٌ منه . فإِنه يكفي في الدَّلالة على سقوطهِ وقلَّةِ تمييز القائل به أن يقتضيَ إِسقاطَ الكناية والاستعارة والتمثيل والمجاز والإيجاز جملة واطِّراحَ جميعها رأساً مع أنها الأقطابُ التي تَدورُ البلاغةُ عليها والأَعضادُ التي تستند الفصاحةُ إِليها والطِّلبةُ التي يتَنازعها المُحسِنون والرِّهان الذي تجرَّب فيه الجياد والنِّضال الذي تُعرفُ به الأيدي الشِّداد وهي التي نَوّه بذكرها البُلغاءُ ورفعَ من أقدارها العَلماءُ وصنَّفوا فيها الكتب ووكَّلوا بها الهِمَم وصرَفوا إِليها الخَواطرَ حتّى صارَ الكلامُ فيها نوعاً من العلم مُفرداً وصناعةً على حِدَة ولم يتعاطَ أحدٌ من الناس القولَ في الإِعجاز إِلاّ ذكرَها وجعلَها العُمُدَ والأركانَ فيما يوجب الفضلَ والمزية وخصوصاً الاستعارة والإِيجاز . فإِنكَ تراهم يجعلونَهما عنوانَ ما يذكرون وأولَ ما يُوردون وتراهم يذكرونَ من الاستعارة قولَه عزَّ وجل : ( واشْتَعَلَ الرأْسُ شيباً ) وقولَه : ( وأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِم العِجْلَ ) وقولَه عز و جل : ( وآيةٌ لَهُمْ اللّيلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَار ) وقوله عز و جل : ( فاصْدَعْ بِمَا تُؤمَرُ ) وقولَه : ( فلما اسْتَيأسوا منه خَلَصوا نَجيَّاً ) وقولَه تعالى : ( حَتَّى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا ) وقولَه : ( فَما رَبِحَتْ
تِجَارَتُهُمْ ) ومن الإيجاز قولَه تعالى : ( وإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قومٍ خِيانةً فانْبذْ إِليهم عَلى سَوَاءٍ ) وقولَه تعالى : ( ولا يُنْبِئُك مِثْلُ خَبِيرٍ ) وقولَه : ( فشرِّدْ بِهم مِنْ خَلْفَهُمْ ) . وتراهم على لسانٍ واحدٍ في أن المجازَ والإِيجازَ من الأركانِ في أمرِ الإِعجاز
وإِذا كان الأمرُ كذلك عندَ كافَّة العُلماءِ الذين تكلَّموا في المَزايا التي للقُرآن فَيَنْبغي أن يَنْظُرَ في أمْرِ الذي يُسْلِمُ نفسَه إِلى الغرورِ فيزعمُ أن الوَصْفَ الذي كانَ له القرآنُ مُعجزاً هو سَلامةُ حروفِه ممّا يَثْقُلُ على اللِّسانِ . أيصحُّ له القولُ بذلك إِلاّ مِنْ بَعْدِ أنْ يَدَّعيَ الغلطَ على العقلاءِ قاطبةً فيما قالوه والخطأَ فيما أجمعوا عليه وإِذا نَظَرْنا وجدناهُ لا يصحُّ له ذلك إِلاَّ بأنْ يقتحمَ هذه الجَهَالَة . اللهم إِلاّ أنْ يخرجَ إِلى الضُّحْكَةِ فيزعمَ مثلاً أنَّ من شأنِ الاستعارةِ والإيجازِ إِذا دَخلا الكلامَ أن يحدُثَ بهما في حروفِهِ خِفَّةٌ ويتجدَّدَ فيها سُهولةٌ . ونسألُ اللهَ تعالى العصمةَ والتوفيقَ
واعلمْ أنّا لا نأبى أَنْ تكونَ مَذاقةُ الحروفِ وسلامَتُها مما يَثْقُلُ على اللِّسانِ داخلاً فيما يوجبُ الفضيلة وأَنْ تكونَ مما يؤكِّدُ أمرَ الإِعجازِ . وإِنما الذي نُنْكِرُه ونُفيِّلُ رأيَ من يذهبُ إِليه أن يجعَلهُ مُعجزاً به وحدَه ويجعلَه الأصلَ والعمدَةَ فيخرجَ إِلى ما ذكرنا من الشِّناعات
ثم إِنَّ العجبَ كلِّ العجبِ ممّن يجعلُ كلَّ الفضيلةِ في شيءٍ هو إِذا انفردَ لم يَجِبْ به فضلٌ البتةَ ولم يدخُلْ في اعتدادٍ بحالٍ . وذلك أنه لا يَخْفَى على عاقل أنه لا يكونُ بسهولةِ الألفاظِ وسلامَتِها مما يثقلُ على اللسانِ اعتدادٌ حتى يكونَ قد أُلِّفَ منها كلام . ثم كان ذلك الكلامُ صحيحاً في نظمه والغرض الذي أريد به . وأنه لو عَمَدَ عامدٌ إِلى ألفاظٍ فجمعَهَا من غيرَ أن يراعيَ فيها معنًى ويؤلِّفَ منها كلاماً لم تَرَ عاقلاً يعتدُّ السهولةَ فيها فضيلةً . لأنَّ الألفاظَ لا تُرادُ لأنفسِها وإِنما تُرادُ لتجعلَ أدلةً على المعاني . فإِذا عَدِمَتِ الذي له تُراد أو اختلَّ أمرُها فيه لم يُعتدَّ بالأوصاف التي تكون في أنفسِها عليها وكانتِ السُّهولةُ وغَيْرُ السّهولة فيها واحداً . ومن هاهنا رأيتُ العلماءَ يذمُّون مَنْ يحمِلُه تطلُّبُ السَّجَعِ والتجنيس على أنْ يضُمَّ لهما المعنى ويدخلَ الخللُ عليه من أجلِهما وعلى أنْ يتعسَّفَ في الاستعارةِ بسببهما ويركَب الوعورةَ ويسلكَ المسالكَ المجهولَةَ كالذي صَنَع أبو تمام في قولِه - البسيط
( سيفُ الإمام الذي سَمَّتْهُ هيبتُه ... لما تَخَرَّمَ أهلَ الأرضِ مُخْترِما )
( قَرَّتْ بِقُرَّانَ عينُ الدينِ وانتشرتْ ... بالأشترينِ عيونُ الشِّرْكِ فاصطُلِما )
وقولهِ - الكامل - :
( ذَهَبَتْ بمذهبِهِ السَّماحَةُ والتَوتْ ... فيه الظنونُ أمَذْهبٌ أم مُذْهَبُ )
ويصنَعه المتكلِّفون في الأسجاعِ وذلك أنه لا يتصوَّر أن يجبَ بهما ومِنْ حيثُ هما فضلٌ ويقعَ بهما مع الخلوِّ منَ المعنى اعتدادٌ . وإِذا نظرتَ إِلى تجنيسِ أبي تمام : " أمَذهَبٌ أم مُذهَبُ " فاستضعفتَه وإِلى تجنيس القائل - البسيط - :
( حتَّى نجا من خَوفِهِ وما نَجا ... )
وقولِ المحدَثِ - الخفيف - :
( ناظِراه فيما جَنَى ناظِراهُ ... أو دَعَاني أمُتْ بما أوْدَعاني )
فاستحسنتَه لم تشكَّ بحالٍ أنَّ ذلك لم يكنْ لأمرٍ يرجعُ إِلى اللفظِ ولكنْ لأنّك رأيتَ الفائدةَ ضعفتْ في الأول وقويتْ في الثاني . وذلك أنكَ رأيتَ أبا تمامٍ لم يَزِدْكَ ب " مَذهب " و " مُذْهَبِ " على أن أسمَعك حروفاً مكرَّرة لا تجدُ لها فائدةً - إِن وجدتَ - إِلاّ متكلَّفة متمحَّلة . ورأيتَ الآخرَ قد أعاد عليك اللَّفْظَة كأنَّه يخدعُكَ عَنِ الفائدة وقد أعطاها . ويوهمُك أنه لم يَزدْك وقد أحسنَ الزيادةَ ووفّاها . ولهذهِ النكتةِ كانَ التجنيسُ وخصوصاً المستوفَى منه مثلَ : " نجا ونجا " من حُليِّ الشعر والقولُ فيما يَحْسُنُ وفيما لا يَحْسُنُ من
التجنيسِ والسجعِ يطولُ . ولم يكن غرضُنا من ذكرهما شرحَ أمرهما ولكنْ توكيدُ ما انتهى بنا القول إِليه مِن استحالة أن يكونَ الإِعجازُ في مجرَّدِ السُّهولَةِ وسَلامةِ الألفاظِ مما يثقُلُ على اللسانِ
وجملةُ الأمر أنّا ما رأينا في الدنيا عاقلاً اطَّرَح النَظْمَ والمحاسِنَ التي هو السببُ فيها في الاستعارةِ والكنايةِ والتمثيلِ وضروبِ المجازِ والإيجازِ وصدَّ بوجهه عَنْ جميعها وجعلَ الفضلَ كلَّه والمزيةَ أجمعَها في سلامَةِ الحروفِ مما يثقلُ كيفَ وهو يؤدِّي إِلى السُّخفِ والخروجِ من العَقْلِ كما بيّنا
واعلمْ أنه قد آنَ لنا أن نعودَ إِلى ما هو الأمرُ الأعظمُ والغرضُ الأهمُّ والذي كأنه هو الطِّلبةُ وكلُّ ما عداهُ ذرائعُ إِليه وهو المرامُ وما سواه أسبابٌ للتسلُّق عليه . وهو بيانُ العِلَلِ التي لها وَجَبَ أن يكونَ لنظمٍ مزيةٌ على نَظْمٍ وأن يَعمَّ أمرُ التفاضُلِ فيه ويتنَاهى إِلى الغاياتِ البعيدةِ . ونحن نسألُ الله تعالى العونَ على ذلِكَ والتوفيقَ له والهدايةَ إِليه
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في أهمية السياق للمعنى
ما أظنُّ بكَ أيها القارىء لكتابِنا إِن كنتَ وفَّيته حقَّه من النظرِ وتدبَّرتَه حقَّ التدبرِ إِلاّ أنكَ قد علمتَ علماً أَبى أن يكون للشكِّ فيه نصيبٌ وللتوقّفِ نحوكَ مذهبٌ أنْ ليس النظمُ شيئاً إِلاّ توخيِّ معاني النحو وأحكامِه ووجوهِه وفروقه فيما بَيْنَ معاني الكلم . وأنك قد تبيّنتَ أنه إِذا رُفِعَ معاني النَّحو وأَحكامُه مما بينَ الكلمِ حتى لا تُرادَ فيها في جملةٍ ولا تفصيلٍ خرجت الكلم المنطوقُ ببعضِها في أثرِ بعضٍ في البيتِ من الشعرِ والفصلِ من النَثْر عن أنْ يكونَ لكونِها في مواضِعِها التي وُضِعَتْ فيها مُوجبٌ ومُقتضٍ وعنْ أن يتصوَّر أن يقالَ في كلمة منها إِنها مرتبطةٌ بصاحبةٍ لها ومتعلِّقةٌ بها وكائنةٌ بسببٍ منها وأنَّ حسنَ تصوُّرك لذلك قد ثَبَّتَ فيه قَدَمَكَ وملأ مِنَ الثقةِ نفسَك وباعدَك من أن تحِنَّ إِلى الذي كنتَ عليه وأن يَجُرَّكَ الإِلفُ والاعتيادُ إِليه وأنك جعلتَ ما قلناه نقشاً في صدركَ وأثبتَّهُ في سويداءِ قلبكَ وصادقتَ بينَه وبينَ نفسِك . فإِنْ كانَ الأمرُ كما ظنناه رجونا أن يصادفَ الذي نريدُ أن نستأنفَه بعونِ الله تعالى منكَ نيةً حسنةً تقيكَ المللَ ورغبةً صادقةً تدفعُ عنكَ السأمَ وأَرْيحيةً يخفُّ معها عليك تعبُ الفِكْر وكدُّ النظر . واللهُ تعالى وليُّ توفيقك وتوفيقنا بمنّهِ وفضلهِ . ونبدأ فنقول :فإِذا ثبتَ الآن أنْ لا شَكَّ ولا مِرْيَةَ في أنْ ليس النظمُ شيئاً غيرَ توخّي معاني النحو وأحكامه فيما يبنَ معاني الكلم ثبتَ من ذلك أنَّ طالبَ دليلِ الإِعجازِ مِنْ نَظْمِ القرآنِ إِذا هو لم يطلبه في معاني النحوِ وأحكامِه ووجوهِه وفروقِه ولم يَعْلمْ أنها معدِنُه ومعانه وموضعه ومكانُه وأنه لا مُستنبَط له سِواها وأنْ لا وجهَ لطلبهِ فيما عداها غارٌ نفسَه بالكاذب من الطَمَع ومُسْلمٌ لها إِلى الخُدَع وأنهُ إِنْ أبى أن يكونَ فيها كان قد أبى أنْ يكون القرآنُ معجزاً بنظمه ولَزِمَه أن يُثبتَ شيئاً آخرَ يكونُ مُعجزاً به وأنْ يلحقَ بأصحابِ الصَّرفة
فيدفعَ الإِعجازَ من أصلِه . وهذا تقريرٌ لا يدفعه إِلا مُعانِدٌ يَعُدّ الرجوعَ عن باطلٍ قد اعتقدَه عجزاً والثَّباتَ عليه مِنْ بَعْدِ لزوم الحجَّةِ جلداً ومَنْ وضع نفسَه في هذه المنزلةِ كان قد باعَدَها من الإِنسانية . ونسألُ الله تَعالى العصمةَ والتوفيقَ
وهذه أصولٌ يحتاجُ إِلى معرفَتِها قبل الذي عَمَدنا به
اعلمْ أن معاني الكلام كلَّها معانٍ لا تُتصوَّر إِلا فيما بين شيئين . والأصل والأولُ هو الخبر . وإِذا أحكمتَ العلم بهذا المعنى فيه عرفتَه في الجميع . ومن الثابتِ في العقولِ والقائمِ في النفوسِ أنه لا يكونُ خبرٌ حتى يكونَ مخبَرٌ به وَمُخبرٌ عنه لأنه ينقَسِم إِلى إِثباتٍ ونفي . والإِثبات يَقْتَضي مُثبتاً ومُثبتاً له . والنفيُ يقتضي مَنفياً ومنفياً عنه . فلو حاولتَ أنْ يتصوَّرَ إثبات معنى أو نَفْيُهُ مِنْ دون أن يكونَ هناكَ مُثبتٌ له ومنفيٌّ عنه حاولتَ ما لا يَصِحُّ في عَقْلِ ولا يقعُ في وهم . ومن أجلِ ذلك امتنعَ أن يكونَ لك قصدٌ إِلى شيء مُظْهَرٍ أو مقدَّرٍ مُضْمَر . وكان لفظُكَ به إِذا أنتَ لم تُرِدْ ذلك وصوتٌ تصِّوتُه سواء
وإِن أُردتَ أن تستحكم معرفةُ ذلكَ في نفسِكَ فانظرْ إِليك إِذا قيلَ لك : ما فعلَ زيدٌ فقلتَ : خرجَ . هَلْ يتصوَّرُ أن يقعَ في خَلَدِك من " خرج " معنى مِنْ دون أن تَنويَ فيه ضميرَ زيد وهل تكونُ إِن أنتَ زعمتَ أنك لم تنوِ ذلك إِلا مُخْرِجاً نفسَك إِلا الهَذَيان وكذلكِ فانظر إِذا قيلَ لك : كيفَ زيدٌ فقلتَ : صالحٌ هل يكونُ لقولِكَ : " صالح " أثرٌ في نفسِك من دون أن تريدَ " هو صالح " أم هل يَعْقِلُ السامعُ منه شيئاً إِن هو لم يعتقد ذلك فإِنه مما لا يبقَى معه لعاقل شَكٌّ أن الخبرَ معنًى لا يتصوَّر إِلا بين شيئينِ يكون أحدُهما مُثبَتاً والآخَرُ مثبَتًا له أو يكون أحدُهما منفياً والآخَرُ منفياً عنه وأنه لا يتصوّر مثَبتُ من غيرِ مثبَتٍ له ومنفيٌّ من دونِ منفيٍّ عنه . ولما كان الأمرُ كذلكَ أوجبَ ذلك أن لا يعقلَُ إِلاّ من مجموع جملةِ فعلٍ واسمٍ كقولِنا : خرجَ زيدٌ أو اسمٍ واسمٍ كقولنا : زيدٌ منطلقٌ . فليس في الدنيا خبرٌ يعرفُ من غيرِ هذا السبيلِ وبغيرِ هذا الدليلِ . وهو شيء يعرفُه العقلاء في كلِّ جيل وأمة وحكمٌ يجري عليه الأمرُ في كلِّ لسانٍ ولغةٍ
وإِذْ قَدْ عَرَفْتَ أنه لا يُتصوَّر الخبرُ إِلاّ فيما بينَ شيئين : مخبرٍ به ومخبرٍ عنه فينبغي أن يُعْلَمَ أنهُ يحتاجُ مِنْ بَعد هذين إِلى ثالثٍ . وذلك أنه كما لا يتصوَّر أن يكونَ هاهُنا خبرٌ حتى يكونَ مخبرٌ بهِ ومخبَر عنه . كذلك لا يُتصوّر أن يكونَ خبرٌ حتى يكونَ له مُخبِرٌ يصدرُ عنه ويحصلُ من جهته ويكونَ له نِسبةٌ إِليه وتعودُ التَّبعةُ فيه عليه . فيكونَ هو الموصوفَ
بالصدق إِن كان صدقاً وبالكَذِب إِن كان كَذباً . أفلا تَرى أن من المعلوم أنه لا يكون إِثباتٌ ونفيٌ حتى يكونَ مثبتٌ ونافٍ يكون مصدرُهما من جهته ويكون هو المُزْجِيَ لهما والمبرِمَ والناقِضَ فيهما ويكونَ بهما مُوافقاً ومُخالفاً ومصيباً ومخطئاً ومحسناً ومسيئاً
وجملةُ الأمرِ أنَّ الخبرَ وجميعَ الكلامِ معانٍ ينشِئُها الإِنسانُ في نفسهِ ويصرفُها في فكرهِ ويناجي بها قلبَه ويراجعُ فيها عقلَه وتوصَفُ بأنَّها مقاصدُ وأغراضٌ وأعظمُها شأناً الخبرُ فهو الذي يتصوَّر بالصُوَرِ الكثيرة وتقعُ فيه الصناعاتُ العجيبةُ . وفيه يكونُ في الأمرِ الأعمِّ المزايا التي بها يقعُ التفاضُلُ في الفصاحَةِ كما شرحنا فيما تقدَّم ونشرحُه فيما نقولُ من بعدُ إِنْ شاءَ الله تعالى
واعلمْ أنك إِذا فتشتَ أصحابَ اللفظِ عمّا في نفوسِهِم وجدتَهم قد توهَّموا في الخبر أنه صِفَةٌ للفظ وأن المعنى في كونِه إِثباتاً أنه لفظ يدلُّ على وجود المعنى من الشيء أو فيه وفي كونه نفياً أنه لفظ يدلّ على عدمه وانتفائه عن الشيء . وهو شيءٌ قد لَزمَهم وسَرَى في عروقِهم وامتزجَ بطباعِهم حتى صارَ الظَنُّ بأكثرهم أن القولَ لا ينجعُ فيهم . والدليلُ على بطلانِ ما اعتقدوه أنه محالٌ أن يكون اللفظُ قد نُصِبَ دليلاً على شيءٍ ثم لا يحْصُل منه العِلْمُ بذلك الشيء إِذ لا معنى لكونِ الشيء دليلاً إِلا إِفادته إِياكَ العلمَ بما هو دليلٌ عليه
وإِذا كان هذا كذلك عُلِم منه أنْ ليسَ الأمرُ على ما قالوه من أن المعنى في وصفنا اللفظَ بأنَّه خبرٌ أنه قد وُضِعَ لأن يدلَّ على وجودِ المعنى أو عَدَمِه لأنه لو كانَ كذلكَ لكانَ ينبغي أن لا يقعَ من سامِعٍ شكٌّ في خبرٍ يَسْمَعُه وأن لا تسمعَ الرجلَ يثبتُ وينفي إِلا علمتَ وجودَ ما أثبتَ وانتفاء ما نفى . وذلكَ مما لا يُشَكُّ في بُطلانِهِ . وإِذا لم يكنْ ذلك مما يُشَكُّ في بطلانِهِ وَجَبَ أن يُعْلَمَ أنَّ مدلولَ اللفظ ليس هو وجودَ المعنى أو عدمَه ولكنِ الحكمُ بوجود المعنى أو عَدمِه وأن ذلك أي الحكمُ بوجود المعنى أو عدمِه حقيقةُ الخبر . إِلاّ أنه إِذا كان بوجودِ المعنى منَ الشيء أو فيه يسمى إِثباتاً . وإِذا كان بِعَدَم المعنى وانتفائهِ عن الشيء يسمَّى نفيا . ومن الدليل على فسادِ ما زعموه أنه لو كان معنى الإثبات الدلالةَ على وجود المعنى وإِعلامَه السامعَ أيضاً لكان ينبغي إِذا قال واحدٌ : " زيد عالم " وقال آخر " " زيدٌ ليس بعالمٍ " أن يكونَ قد دلَّ هذا على وجودِ العلم وهذا على عدمه . وإِذا قال الموحِّدُ : العالَمُ مُحْدَثٌ " وقال المُلْحِدُ : " هو قديمٌ " أن يكونَ قد دَلَّ الموحِّدُ على حدوثِه والملحِدُ على قِدَمِه وذلك ما لا يقوله عاقل
تقريرٌ لذلك بعبارة أخرى : لا يتصوَّر أن تَفْتَقِرَ المعاني المدلولُ عليها بالجمل المؤلَّفة إلى دليلٍ يدُلُّ عليها زائدٍ على اللفظ . كيف وقد أجمعَ العقلاءُ على أن العِلْمَ بمقاصِد الناس في محاوراتِهم علمُ ضرورةٍ . ومن ذَهَب مذهباً يقتضي أن لا يكونَ الخبرُ معنًى في نفسِ المتكلِّمِ ولكن يكونُ وصفاً للفظ من أجلِ دلالتِه على وجودِ المعنى من الشيءِ أو فيه أو انتفاءِ وجودِه عنه كان قد نقضَ منه الأصْلَ الذي قَدَّمناه من حيثُ يكونُ قد جعلَ المعنى المدلول عليه باللفظ لا يعرفُ إِلا بدليلٍ سوى اللفظِ ذاك لأنَّا لا نعرفُ وجودَ المعنى المُثْبَتِ وانتفاءَ المنفيِّ باللفظ . ولكنا نَعْلَمُه بدليلٍ يقومُ لنا زائدٍ على اللفظِ . وما منْ عاقلٍ إِلاّ وهو يعلمُ ببديهةِ النظر أن المعلومَ بغيرِ اللفظ لا يكونُ مدلولَ اللفظ
طريقة أخرى : الدلالةُ على الشيء هي لا محالة إِعلامُك السامعَ إِياه وليس بدليلٍ ما أنتَ لا تعلمُ به مدلولاً عليه . وإِذا كان كذلك وكان مما يُعْلم ببدائه المعقولِ أن الناسَ إِنما يكلِّم بعضُهم بعضاً ليعرفَ السامِعُ غرضَ المتكلِّم ومقودَه فينبغي أن يَنْظُرَ إِلى مقصودِ المُخْبر من خَبرِه وما هو أهو أن يُعلم السامعَ وجودَ المُخْبر من المخبَرِ عنه أم أن يعلمَه إثبات المعنى المخبرَ به للمخبَرِ عنه فإِنْ قيلَ : إِن المقصودَ إِعلامُه السامعَ وجودَ المعنى من المخبر عنه . فإِذا قال : ضربَ زيدٌ كان مقصودُه أن يُعلمَ السامعَ وجودَ الضرب من زيدٍ وليس الإِثباتُ إِلا إِعلامَه السامعَ وجودَ المعنى قيل له : فالكافرُ إِذا أثبتَ مع الله - تعالى عما يقول الظالمون - إلهاً آخر يكونُ قاصداً أن يَعْلَم - نعوذ بالله تعالى - أن مع الله تعالى إلهاً آخر تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وكفى بهذا فضيحةً
وجملةُ الأمرِ أنه ينبغي أنْ يقالَ لهم : أتشكُّونَ في أنه لا بُدَّ منْ أَن يكونَ لخبر المخبر معنًى يعلمُه السامعُ علماً لا يكونُ معه شكٌّ ويكون ذلكَ معنى اللفظِ وحقيقته فإِذا قالوا : لا نشكُّ . قيل لهم : فما ذلك المعنى فإِن قالوا : هو وجودُ المعنى المخبرَ به مَن المخبر عنه أو فيه إِذا كان الخبرُ إِثباتاً وانتفاؤه عنه إِذا كان نفياً لم يمكنهم أن يقولوا ذلك إِلاّ من بعد أن يكابروا فيدَّعوا أَنَّهم إِذا سَمِعوا الرجلَ يقولُ : خرجَ زيدٌ علموا علماً لا شَكَّ معه وجودَ الخروج من زيد . وكيف يدَّعون ذلكَ وهو يقتضي أن يكونَ الخبرُ على وفقِِ المخبَرِ عنه أبداً وأن لا يجوزَ فيه أن يقع على خلافِ المخبر عنه . وأن يكونَ العقلاءُ قد غَلِطوا حينَ جعلوا من خاصِّ وصفهِ أنه يحتملُ الصدقَ والكذبَ وأن يكونَ الذي قالوه في أخبارِ الآحادِ
وأخبارِ التَّواترِ من أنَّ العلمَ يقعُ بالتواتر دونَ الآحادِ سَهواً منهم . ويقتضي الغنى عن المعجزةِ لأنه إِنما احتيجَ إِليها ليحصلَ العلمُ بكونِ الخبر على وِفْق المخبَرِ عنه . فإِذا كان لا يكون إِلاّ على وفقِ المخبر عنه لم تَقَعِ الحاجةُ إِلى دليلٍ يدل على كونه كذلك فاعرفه
واعلمْ أنه إِنما لزمهُمْ ما قُلناه من أن يكونَ الخبرُ على وِفق المخْبَرِ عنه أبداً من حيثُ إِنه إِذا كان معنى الخبر عندهم إِذا كان إِثباتاً أنه لفظٌ موضوعٌ ليدلَّ على وجود المعنى المخَبر به من المخبر عنه أو فيه وجبَ أن يكون كذلك أبداً وأن لا يصحَّ أن يقالَ : ضرب زيد إِلاّ إِذا كانَ الضربُ قد وُجِد من زيد . وكذلك يجبُ في النفي أن لا يصحَّ أن يقالَ : ما ضربَ زيد إِلاّ إِذا كان الضربُ لم يوجد منه لأن تجويزَ أنْ يقالَ : ضربَ زيدٌ من غير أن يكون قد كان منه ضربٌ وأن يُقال : " ما ضربَ زيدٌ " . وقد كانَ منه ضربٌ يوجبُ على أصلهم إِخلاءَ اللفظ من معناه الذي وُضِعَ ليدلَّ عليه وذلك ما لاَ يُشكُّ في فساده ولا يلزمنا على أصلِنا لأن معنى اللفظ عندنا هو الحكمُ بوجودِ المخبر به من المخبر عنه أو فيه إِذا كان الخبر إِثباتاً والحكم بعدمِه إِذا كان نفيا . واللفظ عندنا لا ينفكُّ من ذلكَ ولا يخلو منه . وذلك لأن قولَنا : " ضربَ وما ضربَ " يدلُّ من قولِ الكاذب على نفس ما يدل عليه من قولِ الصادق . لأنَّا إِن لم نقل ذلك لم يخلُ من أن يزعمَ أن الكاذبَ يُخلي اللفظ من المعنى أو يزعم أنه يجعل للفظ معنًى غيرَ ما وضع لهوكلاهما باطلٌ
ومعلومٌ أنه لا يزالُ يدورُ في كلامِ العقلاء في وصفِ الكاذبِ أنّه يثبتُ ما ليس بثابتٍ وينفي ما ليس بمنتفٍ . والقولُ بما قالوه يؤدي إِلى أن يكونَ العُقَلاءُ قد قالوا المحالَ من حيثُ يجب على أصلِهم أن يكونوا قد قالوا : إِن الكاذبَ يدل على وجودِ ما ليس بموجودٍ وعلى عدمِ ما ليس بمعدومٍ وكفى بهذا تهافُتاً وخَطَلاً ودخولاً في اللغو من القول . وإِذا اعتبرنا أصلنا كان تفسيرهُ أن الكاذبَ يحكمُ بالوجود فيما ليس بموجودٍ وبالعدم فيما ليس بمعدوم . وهو أسدُّ كلام وأحسنه
والدليلُ على أن اللفظَ من قولِ الكاذب يدلُّ على نفسِ ما يدلُّ عليه من قولِ الصادق إنهم جعلوا خاصَّ وصفِ الخبر أنه يحتَمِل الصدقَ والكَذِبَ . فلولا أنَّ حقيقتَهُ فيهما حقيقةٌ واحدةُ لما كانَ لحدِّهم هذا معنًى . ولا يجوزُ أن يقالَ : إِن الكاذبَ يأتي بالعبارةِ على خلافِ المعبَّر عنه لأن ذلك إِنما يقال فيمن أرادَ شيئاً ثم أتى بلفظٍ لا يصلحُ للذي أراد . ولا يمكننا أن نزعمَ في الكاذب أنه أرادَ أمراً ثم أتى بعبارةٍ لا تصلُحُ لما أراد
ومما ينبغي أن يحصل في هذا الباب أنهم قد أصَّلوا في المفعولِ وكلِّ ما زادَ على جزءي الجملة أن يكون زيادةً في الفائدة . وقد يُخَيَّلُ إلى من ينظر إلى ظاهرِ هذا من كلامهم أنهم أرادوا بذلك أنك تضمُّ بما تَزِيدُه على جزءي الجملة فائدة أخرى وينبني عليه أن ينقطعَ عن الجملة حتى يتصوَّر أن يكون فائدةً على حِدَة وهو ما لا يعقل إذ لا يتصوَّر في زيدٍ من قولك : ضربتُ زيداً أن يكون شيئاً برأسه حتى يكونَ بتعديتك " ضربت " إليه قد ضممتَ فائدة إلى أخرى . وإِذا كان ذلك وجب أن يعلمَ أن الحقيقة في هذا أن الكلامَ يخرج بذكرِ المفعول إلى معنًى غيرِ الذي كان وأن وِزانَ الفعل قد عُدِّي إلى مفعولٍ معهُ وقد أطلق فلم يقصدْ به إلى مفعولٍ دونَ مفعول وزانُ الاسم المخصَّص بالصفةِ مع الاسم المتروك على شَياعه كقولك : " جاءَني رجلٌ ظريفٌ " مع قولك : " جاءني رجلٌ " في أنك لستَ في ذلك كمن يضمُّ معنًى إلى معنًى وفائدةً إلى فائدة ولكن كمن يريدُ هاهنا شيئاً وهناك شيئاً آخر . فإِذا قلتَ : ضربتُ زيداً كان المعنى غيره إذا قلت : " ضربت " ولم تزد " زيداً " . وهكذا يكون الأمرُ أبداً كلَما زدتَ شيئاً وجدتَ المعنى قد صارَ غير الذي كان . ومن أجلِ ذلكَ صَلُح المجازاةُ بالفعل الواحد إذا أتى به مطلقاً في الشرط ومعدًّى إلى شيء في الجزاء كقوله تعالى : ( إن أحسنْتُم أحسنتُم لأنفسكم ) وقولِه عزَّ وجل : ( وإِذا بَطَشتُم بَطَشْتُمُ جَبّارين ) مع العلم بأن الشرطَ ينبغي أن يكونَ غيرَ الجزاء من حيثُ كان الشرطُ سبباً والجزاءُ مسبِّباً وأنه محال أن يكونَ الشيء سبباً لنفسِه . فلولا أن المعنى في " أحسنتُم " الثانية غيرُ المعنى في الأولى وأَنها في حُكْم فعلٍ ثانٍ لما سَاغ ذلك . كما لا يسوغ أن تقول : إنْ قمتُ قمتَ وإن خرجتُ خرجتَ . ومثلُه من الكلام قولُه : " المرءُ بأصغريهِ إن قالَ قال ببيانٍ وإن صالَ صالَ بجَنانٍ " ويجري ذلك في الفعلين قد عُدِّيا جميعاًإلاّ أن الثاني منهما قد تعدَّى إلى شيءٍ زائدٍ على ما تعدَّى إليه الأول . ومثالهُ قولُك : " إن أتاك زيدٌ أتاك لحاجة " . وهو أصلٌ كبير والأدلةُ على ذلك كثيرة ومن أولاها بأن يحفظ أنّك ترى البيتَ قد استحسنه الناسُ وقَضَوا لقائله بالفضلِ فيه وبأنَه الذي غاصَ على معناه
بفكره وأنه أبو عُذْره ثم لا ترى الحسنَ وتلك الغرابة كانا إلا لِما بناهُ على الجملةِ دونَ نفسِ الجملةِ . ومثالُ ذلك قولُ الفرزدق - الطويل - :
( وما حَمَلتْ أمُّ امرىءٍ في ضُلوعِها ... أعقَّ منَ الجاني عَليها هِجائيا )
فلولا أن معنى الجملة يصيرُ بالبناءِ عليها شيئاً غيرَ الذي كان ويتغيَّر في ذاتِه لكان محالاً أن يكونَ البيتُ بحيثُ تراه من الحُسْنِ والمزيّة . وأن يكونَ معناه خاصاً بالفرزدقِ وأن يقضيَ له بالسبق إليه إذ ليس في الجملة التي بُني عليها ما يوجب شيئاً من ذلك فاعرفه
والنكتة التي يجب أن تُراعَى في هذا أنه لا تتبينُ لك صورةُ المعنى الذي هو معنى الفرزدق إلاّ عند آخرِ حرفٍ من البيت . حتى إن قطعتَ عنه قولَه : " هجائياً " بل الياء التي هيَ ضمير الفرزدق لم يكن الذي تعقلُه منه ممَّا أراده الفرزدق بسبيل لأن غرضه تهويلُ أمر هجائه والتحذيرُ منه . وأنّ من عرَّض أمَه له كان قد عرَّضَها لأعظم ما يكونُ من الشرِّ . وكذلك حكمُ نظائِرهِ من الشِّعْرِ . فإِذا نظرتَ إلى قول القُطامي - البسيط - :
( فهنَّ يَنْبُذنَ من قولٍ يُصبْنَ بهِ ... مَواقعَ الماءِ من ذي الغُلَّةِ الصَّادي )
وجدتُك لا تحصلُ على معنًى يصحُّ أن يقالَ إنه غرضُ الشاعرِ ومعناه إلاّ عند قولهِ : " ذي الغلة " . ويزيدك استبصاراً فيما قلناه أن تنظرَ فيما كانَ من الشِّعْرِ جُملاً قد عُطِفَ بعضُها على بعضٍ بالواو كقوله - الكامل - :
( النَّشرُ مِسْكٌ والوجوه دنانيرُ ... وأطرافُ الأكفِّ عَنَمْ )
وذلك أنك ترى الذي تعقِلُه من قولِه : " النَشرُ مسكٌ " لا يصيرُ بانضمام قوله : " والوجوهُ دنانيرُ " إليه شيئاً غير الذي كان بل تراه باقياً على حاله . كذلك ترى ما تعقلِ من قولِه " والوجوهُ دنانيرُ " لا يلحَقُه تغيرُ بانضمام قوله : " وأطرافُ الأكفِّ عَنم " إليه
وإِذ قد عرفتَ ما قرّرناه من أنَّ من شأنِ الجملة أن يصير معناها بالبناء عليها شيئاً غيرَ الذي كان وأنه يتغيِّر في ذاته فاعلم أن ما كان من الشِّعرْ مثل بيت بشار - الطويل - :
( كأنَّ مُثارَ النَّقْعِ فوقَ رؤوسنا ... وأَسيافَنا ليل تَهاوَى كواكبهْ )
وقولِ امرىء القيس - الطويل - :
( كأنَّ قلوبَ الطَّيرِ رطْباً ويابساً ... لدى وَكْرِها العُنَّابُ والحَشَفُ البالي )
وقولِ زياد - الطويل - :
( وإنّا وما تُلْقي لنا إنْ هَجَوتنا ... لكالبحر مَهْما يُلْقَ في البحرِ يَغْرَقِ )
كان له مزيةٌ على قول الفرزدق فيما ذكرنا لأنك تجدُ في صدرِ بيتِ الفرزدق جملةً تؤدي معنًى وإِن لم يكن معنًى يصحُّ أن يقال : " إنه معنى فلان " . ولا تجدُ في صدر هذه الأبيات ما يصحُّ أن يعدَّ جملةً تؤدّي معنًى فضلاً عن أن تؤدّي معنى يقال إنه معنى فلان . ذاك لأن قولَه : " كأَنَّ مُثارَ النقع . . إلى : وأسيافنا " جزءٌ واحدٌ و " ليل تهاوى كواكبه " بجملته الجزء الذي ما لم تأتِ به لم تكن قد أتيتَ بكلامٍ وهكذا سبيلُ البيتين الأخيرين . فقولهُ : " كأن قلوبَ الطير رطباً ويابساً لدى وكرها " جزءٌ وقولهُ : " العنابُ والحَشفُ البالي " الجزء الثاني . وقوله :
( وإنَّا وما تُلْقي لنا إِنْ هَجَوتَنا ... )
جزء وقوله : " لكالبحرِ " الجزء الثاني . وقولُه : " مهما تلقِ في البحر يغرقِ " وإن كان جملةً مستأنفة ليس لها في الظاهر تعلّق بقوله : " لكالبحر " فإِنها لما كانت مبيِّنة لحال هذا التشبيه صارتْ كأنَّها متعلَّقة بهذا التّشبيه وجرى مجرى أن تقولَ : " لكالبحر في أنَّه لا يُلقى فيه شيء إلاّ غرق "
فصل في الألفاظ المفردة والوضع والنظم
وإِذا ثَبتَ أن الجملة إذا بُني عليها حَصَل منها ومِنَ الذي بُني عليها في الكثير معنًى يجب فيه أن ينسبَ إلى واحد مخصوص فإِن ذلك يقتضي لا محالة أن يكونَ الخبرُ في نفسه معنى هو غيرُ المخبر به والمخبر عنه . ذاك لعلمنا باستحالة أن يكون للمعنى المخبر به نسبةٌ إلى المخبر وأن يكون المستنبطَ والمستخرجَ والمستعانَ على تصويره بالفكر فليس يَشُكُّ عاقلٌ أنه محال أن يكون للحمل في قوله :( وما حملتْ أَمُّ امرىءٍ في ضلوعها ... )
نسبة إلى الفرزدق وأن يكون الفكر منه كانَ فيه نفسه وأن يكون معناه الذي قيل إنه استنبطه واستخرجه وغاصَ عليه . وهكذا السبيل أبداً لا يتصوَّر أن يكون للمعنى المخبَرِ به نسبةٌ إلى الشاعر وأن يبلغ من أمره أن يصير خاصّاً به فاعرفه
ومن الدليل القاطع فيه ما يبّناه في الكنايةِ والاستعارة والتمثيل وشرحناه من أن من شأن هذه الأجناسِ أن توجِبَ الحسنَ والمزية وأن المعاني تتصوَّر من أجلها بالصور المختلفة وأن العلمَ بإيجابها ذلك ثابتٌ في العقولِ ومركُوزٌ في غرائزِ النفوسِ وبيّنا كذلك أنه محال أنْ تكونَ المزايا التي تحدثُ بها حادثة في المعنى المخبر به المثبت أو المنفي لعلمنا باستحالة أن تكونَ المزيةُ التي تجدها لقولنا : " هو طويلُ النجاد " علىقولنا : " طويل القامة " في الطول والتي تجدُها لقولنا : " هو كثيرُ رمادِ القدر " على قولنا : " هو كثيرُ القرى والضِّيفاة " في كَثرةِ القرى . وإذا كان ذلك محالاً ثبت أن المزية والحُسْن يكونان في إثبات ما يراد أن يوصفَ به المذكورُ والإِخبارُ به عنه . وإذا ثَبَت ذلك ثَبَتَ أن الإِثبات معنًى لأَن حصولَ المزية والحسن فيما ليس بمعنى محال
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه ثقتي وعليه اعتمادي
اعلمْ أنَ هاهنا أصلاً أنت ترى الناسَ فيه في صورة من يعرِفُ من جانبٍ وينكر من آخر وهو أن الألفاظَ المفردةَ التي هي أوضاعُ اللغة لم توضَع لتعرفَ معانيها في أنفسها ولكن لأن يُضَمَّ بعضُها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد وهذا علمٌ شريف وأصلٌ عظيم . والدليلُ على ذلك أنَّا إن زعمنا أن الألفاظ التي هي أوضاع اللغة إنما وضعت ليعرفَ بها معانيها في أنفسِها لأَدَّى ذلك إلى ما لا يَشُكُّ عاقلٌ في استحالته وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس الأسماءَ التي وضعوها لها لتعرفها بها حتّى كأنهم لو لم يكونوا قالوا : رجلٌ وفرسٌ ودارٌ لما كان يكون لنا علمٌ بمعانيها . وحتى لو لم يكونوا قالوا : فعل ويفعل لمَا كنا نعرِفُ الخبر في نفسه ومن أَصْله . ولو لم يكونوا قَدْ قالوا : افعلْ لما كنا نعرف الأمر من أصله ولا نجده في نفوسنا . وحتّى لو لم يكونوا قد وَضَعوا الحروفَ لكنّا نجهلُ معانيها فلا نعقِل نفياً ولا نهياً ولا استفهاماً ولا استثناء . وكيف والمُواضَعَةُ لا تكون ولا تتصوّر إلاّ على معلوم . فمحالٌ أن يُوضعَ اسمٌ أو غيرُ اسم لغير معلوم ولأنَّ المواضَعة كالإِشارة فكما أنك إذا قلتَ : خُذْ ذاك لم تكن هذه الإشارةُ لتعرِّفَ السامعَ المشارَ إليه في نفسِه ولكن ليعلم أنه المقصودُ من بين سائرِ الأشياء التي تراها وتُبصرُها كذلك حكمُ اللفظ مع ما وُضع له . ومَن هذا الذي يَشُكُّ أنَّا لم نَعْرفِ الرجلَ والفرسَ والضربَ والقتل إلا من أساميها لو كان لذلك مساغٌ في العقل لكان ينبغي إِذا قيل : زيد أن تعرف المسمى بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدتَه أو ذُكر لك بصفةوإِذا قلنا في العِلْم واللغاتِ من مبتدأ الأمر إنّه كان إلهاماً فإِنَّ الإِلهام في ذلك إنما يكون بين شيئين يكونُ أحدُهما مثبتاً والآخر مثبتاً له أو يكون أحدُهما منفياً والآخرُ منفياً
عنه وأنَّه لا يتصوَّر مُثبَتٌ من غيرِ مُثْبِتٍ له ومنفيٌّ من غير مَنْفيٍّ عنه . فلما كان الأمر كذلك أوجبَ ذلك أن لا يعقل إلاّ من مجموع جملةِ فعلٍ واسمٍ كقولِنا : خرجَ زيد أو اسمٍ واسمٍ كقولنا : زيدٌ خارجٌ . فما عقلناه منه وهو نِسْبة الخروج إلى زيد لا يرجعُ إلى معاني اللغات ولكن إلى كون ألفاظِ اللغات سماتٍ لذلك المعنى وكونها مُرادة بها . أفلا تَرى إلى قولهِ تعالى : ( وَعَلَّم آدَمَ الأَسماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ على المَلائِكَةِ فَقال أَنْبِئُوني بأَسْماءِ هؤلاء إنْ كُنْتُمْ صادِقينَ ) أفترى أنه قيلَ لهم : أنبئوني بأسماء هؤلاء وهم لا يعرفون المشارَ إليهم بهؤلاء
ثم إنَّا إذا نظرنا في المعاني التي يَصفُها العقلاءُ بأنها معانٍ مستنبطة ولطائفُ مستخرَجة ويجعلون لها اختصاصاً بقائلٍ دونَ قائلٍ كمثلِ قولهم في معانٍ من الشعر : إنه معنى لم يُسْبَقْ إليه فلان وإنه الذي فَطِن له واستخرجه وإنه الذي غاصَ عليه بفكره وإنه أبو عُذره لم تجد تلك المعاني في الأمر الأعمِّ شيئاً غيرَ الخبر الذي هو إثباتُ المعنى للشيء ونفيهُ عنه . يدلُّك على ذلك أنَّا لا ننظرُ إلى شيءٍ من المعاني الغريبة التي تختصُّ بقائل دونَ قائل إلاّ وجدتَ الأصلَ فيه والأساس الإِثباتَ والنفي . وإن أردتَ في ذلك مثالاً فانظر إلى يبتِ الفرزدق - الطويل - :
( وما حملتْ أمُّ امرىء في ضُلُوعِها ... أعقَّ مِنَ الجاني عليها هِجائيا )
فإِنَّكَ إذا نظرتَ لم تَشُكَّ في الأصلَ والأساس هو قولُه : " وما حملتْ أم امرىء " وأن ما جاوزَ ذلك مِنَ الكلمات إلى آخر البيتِ مستَنِدٌ إليه ومبنيٌّ عليه وأنك إنْ رفعتَه لم تجد لشيء منها بَياناً ولا رأيتَ لذكرها معنًى بل ترى ذكركَ لها إن ذكرتَها هَذَياناً . والسببُ الذي من أجله كان كذلك أنَّ من حكم كل ما عدا جُزْءي الجملة - الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر - أن يكون تحقيقاً للمعنى المُثْبَت والمنفي . فقولُه : في ضلوعِها يفيدُ أولاً أنه لم يُرِدْ نفيَ الحمل على الإِطلاق ولكن الحملَ في الضلوع . وقولهُ : أعقّ يفيد أنه لم يُرِد هذا الحَملَ الذي هو حملٌ في الضلوع أيضاً على الإِطلاق ولكن حملا في الضلوع محمولهُ أعقُّ من الجاني عليها هجاءه . وإِذا كان ذلك كلُّه تخصيصاً للحمل لم يتصوَّر أن يُعْقَلَ من دون أن يَعقل نفي الحملِ لأنه لا يتصوَّر تخصيصَ شيء لم يدخلْ في نفي ولا إثبات ولا ما كان في سبيلهما من الأمر به والنهي عنه والاستخبار عنه
وإِذ قد ثَبَتَ أن الخبرَ وسائرَ معاني الكلام معانٍ يُنشئها الإنسان في نفسِه ويصرفها في فِكْره ويناجي بها قلبَه ويراجعُ فيها لُبَّهُ فاعلم أنَّ الفائدة في العلم بها واقعةٌ من المنشىءِ لها صادرةٌ عن القاصِدِ إليها وإذا قلتَ في الفعل إنه موضوعٌ للخَبَرِ لم يكنِ المعنى فيه أنه موضوعٌ لأن يعلم به الخبرُ في نفسِه وجنسهِ ومن أصله وما هو . ولكنَّ المعنى أنه موضوعٌ حتى إِذا ضَمَمْتَهُ إلى اسمٍ عُقِل منه ومن الاسمِ أن الحُكْم بالمعنى الذي اشتقَّ ذلك الفعل منه على مسمّى ذلك الاسم واقعٌ منك أيها المتكلم
بسم الله الرحمن الرحيم
نماذج تحليلية لأهمية النظم
أعلمْ أنك لن ترى عجباً أَعْجَبَ من الذي عليه الناسُ فِي أمرِ النظم وذلك أنه ما من أحدٍ له أدنى معرفة إلاّ وهو يعلم أن هاهنا نظماً أحسنَ من نظم . ثم تراهم إذا أنتَ أردتَ أن تُبصِّرهم ذلك تَسْدَرُ أعينُهم وتضلُّ عنهم أَفْهَامُهم . وسبب ذلك أنهم أوَّل شيء عَدِموا العلمَ به نفسه من حيث حَسِبوه شيئاً غيرَ توخّي معاني النحو وجعلوه يكونُ في الألفاظِ دونَ المعاني . فأنت تَلقى الجهدَ حتى تُمِيلَهم عن رأيهم لأنَّكَ تُعالج مَرضاً مزمناً . وداءً متمكِّناً . ثم إِذا أنتَ قدتَهم بالخَزَائم إلى الاعترافِ بأن لا معنى له غير توخّي معاني النحو عرضَ لهم من بعدُ خاطرٌ يدهِشُهم حتى يكادوا يَعودون إلى رأس أمرهم . وذلك أنَّهم يروننا ندَّعي المزيَّة والحسنَ لنظم كلامٍ من غير أن يكونَ فيه من معاني النحو شيءٌ يتصوَّر أنْ يتفاضلَ الناس في العلمِ به ويروننا لا نستطيع أن نضعَ اليد من معاني النحو ووجوهِهِ على شيء نزعم أنَّ من شأن هذا أن يوجِبَ المزيَّةَ لكلِّ كلامٍ يكونُ فيه بل يروننا ندَّعي المزيَّةَ لكلِّ ما نَدَّعيها له من معاني النحو ووجوههِ وفروقِه في موضعٍ دونَ مَوْضِعٍ وفي كلامٍ دون كلامٍ وفي الأقلِّ دون الأكثر وفي الواحدِ من الألف . فإِذا رأوا الأمرَ كذلك دخلتهم الشُّبهةُ وقالوا : كيف يصيرُ المعروفُ مجهولاً ومن أين يتصوَّر أن يكون للشيء في كلام مزيةٌ عليه في كلامٍ آخرَ بعد أن تكونَ حَقيقَتُه فيهما حقيقةً واحدة فإِذا رأوا التنكير يكون فيما لا يُحصى منَ المواضِعِ ثم لا يقتضي فضلاً ولا يوجبُ مزيَّةً اتهمونا في دعوانا من ادَّعيناه لتنكير الحياة في قوله تعالى : ( ولكم في القِصاصِ حَياةٌ ) من أنّ له حُسناً ومزية وأن فيه بلاغةً عَجيبة وظَنُّوه وهماً منا وتَخيُّلاً . ولسنا نستطيع في كشفِ الشُّبهة في هذا عنهم وتصويرِ الذي هو الحقُّ عندهم ما استطعناهُ في نفسِ النظم لأنَّا ملكنا في ذلك أن نضطرَّهم إلى أن يعلموا صِحَّةَ ما نقولُ وليس الأمر في هذا كذلك فليس الداءُ فيه بالهين . ولا هو بحيثُ إذا رمتَ العلاجَ منه وجدتَ الإِمكانَ فيه مع كلِّ أحدٍ مُسعفاً والسعي مُنجحاً لأنَّ المزايا التي تحتاج أن تُعْلِمَهم مكانها وتصورَ لهم شأنها أمورٌ خفية ومعانٍ روحانية أنتَ لا تستطيع أن تنبه السامعَ لها وتحدثَ له علماً بها حتّى يكونَ مهيَّأً لإدراكها وتكونَ فيه طبيعة قابلة لها ويكونَ له ذوقٌ وقريحة يجد لهما في نفسه إحساساً بأنَّ من شأنِ هذه الوجوه والفروق أن تعرضَ فيها المزيّةُ على الجُملة وممَّن إذا تصفّح الكلامَ وتَدبَّر الشِعرَ فرَّق بين موقِعِ شيءٍ منها وشيءٍ وممن إِذا أنشدتَه قولَه - السريع - :
( لي منكَ ما للنَّاس كلِّهمِ ... نَظرٌ وتَسْلِيمٌ على الطُرُقِ )
وقولَ البحتري - الكامل - :
( وسَأَسْتَقِلُّ لكَ الدموعَ صَبابةً ... ولَوَ أنَّ دِجلةَ لي عليكَ دموعُ )
وقولَه - الطويل - :
( رأتْ مكْناتِ الشَّيب فابتسمَتْ لها ... وقالتْ نجومٌ لو طَلَعن بأسْعُدِ )
وقولَ أبي نواس - البسيط - :
( ركبٌ تَساقَوا على الأكوارِ بينهُمُ ... كأسَ الكَرى فانتشَى المَسْقيُّ والساقي )
( كأَنَّ أعناقَهم والنومُ واضِعُها ... على المناكِبِ لم تُعْمَدْ بأعناقِ )
وقولَه - الكامل - :
( يا صاحِبيَّ عَصَيْتُ مصْطَبحَا ... وغدوتُ لللَّذَّاتِ مُطَّرِحا )
( فتزوَّدا منِّي مُحادَثةً ... حَذَرُ العصا لم يُبقِ لي مَرَحا )
وقولَ إسماعيلَ بنِ يسار - السريع - :
( حتى إذا الصُّبحُ بدا ضوؤه ... وغابتِ الجوزاءُ والمِرْزَمُ )
( خرجتُ والوطءُ خَفِيٌّ كما ... ينسابُ من مَكْمنهِ الأرقَمُ )
أنقَ لها وأخذتْه أريحيةٌ عندَها وعرف لطفَ موقعِ الحذفِ والتنكيرِ في قوله :
( نظرٌ وتسليمٌ على الطرقِ ... )
وما في قولِ البحتري : " لي عليك دموعُ " من شبه السحرِ وأَنَّ ذلك من أجل تقديم " لي " على " عليك " ثم تنكير الدموع . وعَرَفَ كذلك شرفَ قولِه :
( وقالت نجومٌ لو طلعْنَ بأَسْعُدِ ... )
وعلوّ طبقته ودقَّة صنيعَتِه . والبلاءُ والداء العياء أن هذا الإِحساسَ قليلٌ في الناس حتى إنه ليكونُ أن يقعَ للرجل الشيءُ من هذه الفروقِ والوجوهِ في شِعْرٍ يقوله أو رسالةٍ يكتُبها الموقِعَ الحسنَ ثم لا يعلمُ أنه قد أحسنَ . فأما الجهلُ بمكانِ الإِساءة فلا تَعْدمُه . فلستَ تملِكُ إذاً من أمركَ شيئاً حتى تظفرَ بمَنْ له طبعٌ إذا قدحتَه وَرَى وقلبٌ إذا أريْتَهُ رأى . فأما وصاحِبُكَ مَنْ لا يرى ما تُريه ولا يهتدي للذي تَهديه فأنت رامٍ معه في غيرِ مَرْمًى ومُعَنٍّ نفسك في غيرِ جَدْوى . وكما لا تُقيم الشعرَ في نفسِ مَنْ لا ذوقَ له كذلك لا تُفْهِمُ هذا الشأنَ من لم يؤتَ الآيَة التي بها يَفْهم . إلا أنه إنما يكونُ البلاء إذا ظَنَّ العادمُ لها
أنه أُوتيها وأنه ممَّنْ يكملُ للحكم ويصحُّ منه القضاءُ فجعل يقولُ القولَ لو علم غِيَّه لاسْتَحيا منه . فأما الذين يحسُّ بالنقص من نفسه ويعلم أنه قد علمَ علماً قد أوتيه من سواه فأنتَ منه في راحة وهو رجلٌ عاقلٌ قد حماه عقلُه أن يعدوَ طَورَه وأن يتكلَّفَ ما ليس بأهل به
وإِذا كانَتِ العلومُ التي لها أصولٌ معروفة وقوانينُ مضبوطة قد اشترك الناسُ في العِلْم بها واتفقوا على أن البناءَ عليها إذا أخطأ فيه المخطىء ثم أُعجِبَ برأيه لم يُستَطعْ ردُّه عن هواه وصرفُه عن الرأي الذي رآه إلاّ بَعْدَ الجهد وإلاّ بعد أن يكونَ حَصيفاً عاقلاً ثبتاً إذا نُبِّه انتبه وإِذا قيلَ : إنَّ عليك بقيةً مِنَ النَّظَرِ وقفَ وأصغَى وخشِيَ أن يكونَ قد غُرَّ فاحتاطَ باستماعِ ما يقالُ له وأنفَ من أن يَلِجَّ من غيرِ بيِّنة ويتطيَّلَ بغيرِ حجة . وكان مَنْ هذا وَصفه يعزُّ ويقلُّ فكيف بأن تردَّ الناسَ عن رأيهم في هذا الشأن وأصلُك الذي تردُّهم إليه وتعوِّلُ في مَحاجَّتهم عليه استشهادُ القرائح وسبرُ النفوسِ وفلْيُها وما يعرِضُ فيها من الأريحية عندما تسمع . وكانَ ذلك الذي يفتَح لك سَمْعَهم ويكشِفُ الغطاءَ عن أعينهم ويَصْرِفُ إليك أوجُهَهُم . وهم لا يضعون أنفسهم موضعَ مَنْ يرى الرأيَ ويفتي ويَقْضي إلاّ وعندَهم أنهم ممن صَفَتْ قريحتُه وصحَّ ذوقُه وتمَّتْ أداته
فإِذا قلتَ لهم : " إنكم قد أُتيتُم مِنْ أنفسكم " رَدُّوا عليك مثلَه وقالوا : " لا بل قرائحُنا اصحُّ ونظرُنا أصدقُ وحسُّنا أذكى . وإنما الآفةُ فيكم لأنكم خَيَّلتم إلى نفسِكم أموراً لا حاصلَ لها وأَوهمكم الهوى والميلُ أن تُوجبوا لأحدِ النَّظمين المتساويين فضلاً على الآخر من غيرِ أن يكون ذلك الفضلُ معقولاً " . فتبقى في أيديهم حَسيراً لا تملكُ غيرَ التعجُّبِ . فليس الكلامُ إذاً بمُغْنٍ عنك ولا القولُ بنافعٍ ولا الحجَّةُ مسموعة حتى تجد مَنْ فيه عونٌ لك على نفسِه . ومن أَتى عليك أبى ذاك طبُعُه فردَّه إليك وفَتَحَ سَمْعَه لك ورفَعَ الحجابَ بينك وبينَه وأخذَ به إلى حيثُ أنتَ وصرف ناظِرَه إلى الجهة التي إليها أومأتَ . فاستبدلَ بالنِّفارِ أنساً واراكَ مِنْ بعد الإِباء قَبولاً . ولم يكنِ الأمرُ على هذه الجملة إلاّ لأنه
ليس في أصناف العلومِ الخفية والأمورِ الغامضة الدقيقة أعجبُ طريقاً في الخفاء من هذا . وإنك لَتُتْعِبُ في الشيء نفسَكَ وتكدُّ فيه فكرَكَ وتجهد فيه كلَّ جَهدك . حتى إِذا قلتَ : قد قَتَلْتُه علماً وأحكمتُه فهماً كنتَ الذي لا يزالُ يتراءى لك فيه شُبهةٌ ويعرِضُ فيه شكٌّ . كما قال أبو نواس - الطويل - :
( أَلا لا أرى مثلَ امترائيَ في رَسْمِ ... تَغَصُّ به عَيني ويلفِظُه وَهْمي )
( أتَتْ صورُ الأشياء بَيني وبينهُ ... فظنِّي كلا ظن وعِلْمي كلا علمِ )
وإنك لتنظرُ في البيتِ دهراً طويلاً وتفسِّره ولا ترى أن فيه شيئاً لم تعلمْه . ثم يبدو لك فيه أمرٌ خفيٌّ لم تكن قد علمتَه مثالُ ذلك بيتُ المتنبي - الكامل - :
( عَجَباً لهُ حَفِظَ العِنانَ بأُنْمُلٍ ... ما حِفْظُها الأشياءَ مِن عاداتِها )
مضى الدّهرُ - الطويل - ُ ونحن نقرؤه فلا ننكِرُ منه شيئاً ولا يقعُ لنا أن فيه خطأ ثم بانَ بأَخرَةٍ أنه قد أخطأ . وذلك أنه كان ينبغي أن يقولَ : " ما حفظُ الأشياءِ من عاداتِها " فيضيفَ المَصدرَ إلى المفعولِ فلا يذكرُ الفاعلَ ذاك لأن المعنى على أنّه ينفي الحِفظَ عن أنامله جُملةً وأنه يزعم أنه لا يكونُ منها أصلاً وإضافتُه الحفظَ إلى ضميرِها في قوله : ما حفظها الأشياءَ يقتضي أن يكون قد أثبتَ لها حِفظاً
ونظيرُ هذا أنك تقول : " ليس الخروجُ في مثلِ هذا الوقتِ من عادتي " ولا تقولُ : " ليس خروجي في مثل هذا الوقت من عادتي " . وكذلك تقولُ : " ليس ذمُّ الناسِ من شأني " ولا تقولُ : " ليس ذمِّي الناسَ من شأني " . لأن ذلك يوجبُ إثباتَ الذمِّ ووجوده منك
ولا يصحُّ قياسُ المصدر في هذا على الفعْل أعني لا ينبغي أن يُظَنَّ أنه كما يجوز أن
يقالَ : " ما من عادتها أن تحفظَ الأشياء " كذلك ينبغي أن يجوزَ : " ما مِنْ عادتها حفظُها الأشياء " . ذاك أنَّ إضافةَ المصدر إلى الفاعل يقتضي وجودَه وأنه قد كان منه . يبين ذلك أنك تقولُ : " أمرتُ زيداً بأن يخرجَ غداً " ولا تقول : " أمرتُه بخروجهِ غداً "
ومما فيه خطأ هو في الخفاء قولُه - البسيط - :
( ولا تَشَكَّ إلى خَلْقٍ فتُشْمِتَهُ ... شَكوى الجريحِ إلى الغِرْبان والرَّخَمِ )
وذلك أنك إِذا قلتَ : لا تضجَرْ ضجرَ زيدٍ " كنتَ قد جعلتَ زيداً يضجرُ ضرباً من الضجر مثلَ أن تجعله يُفرطُ فيه أو يسرعُ إليه . هذا هو موجِبُ العرفِ . ثم إن لم تعتبرْ خصوصَ وصفٍ فلا أقلَّ من أن تجعلَ الضجرَ على الجملةِ من عادتِه وأنْ تجعله قد كان منه . وإذا كان كذلك اقتضَى قوله :
( شكوى الجريحِ إلى الغِربانِ والرَّخمِ ... )
أنْ يكونَ هاهنا جريحٌ قد عرف من حاله أن يكون له شكوى إلى الغربان والرخم وذلك محال . وإنما العبارة الصحيحة في هذا أن يقال : لا تَشَكَّ إلى خلقٍ فإِنك إنْ فعلتَ كان مثَلُ ذلكَ مثَلَ أن تصوِّر في وَهْمِك أنّ بعيراً دَبِراً كَشَفَ عن جرحهِ ثم شَكاه إلى الغِربان والرَّخم
ومن ذلك أنك تَرى من العلماءِ مَنْ قد تأَوَّلَ في الشّيء تأويلاً وقَضى فيه بأمرٍ فتعتقده اتِّباعاً ولا ترتابُ أنه على ما قَضَى وتأوّل . وتبقى على ذلك الاعتقادِ الزمانَ - الطويل - َ ثم يلوح لك ما تعلمُ به أن الأمرَ على خلاف ما قدر
ومثالُ ذلك أن أبا القاسم الآمدي ذكرَ بيت البحتري - البسيط - :
( فصاغَ ما صاغَ من تِبْر ومن وَرِقٍ ... وحاكَ ما حاكَ من وَشْيٍ وديباجِ )
ثم قال : صوغُ الغيث وحوكُهُ للنبات ليس باستعارةٍ بلْ هو حقيقةٌ . ولذلك لا يقالُ :
هو صائغَ ولا كأنه صائغ . وكذلك لا يقال : هو حائكٌ وكأنه حائك . قال : على أن لفظَ حائك في غايةِ الركاكة إذا أُخرجَ على ما أخرجَه أبو تمام في قولهِ - الطويل - :
( إِذا الغيثُ غادى نسجَه خِلْتَ أنّه ... خَلَتْ حُقُبٌ حَرْسٌ له وهْوَ حائكُ )
قال : وهذا قبيحٌ جداً . والذي قاله البحتري : " فحاك ما حاكَ " حَسَنٌ مستعمَلٌ . والسببُ في هذا الذي قالَه إنه ذهبَ إلى أن غرضَ أبي تمام أن يقصِدَ ب " خلت " إلى الحَوكِ وأنه أرادَ أن يقولَ : " خلتُ الغيثَ حائكاً " وذلك سهوٌ منه لأنه لم يقصِدْ ب " خلت " إلى لك . وإنما قَصَدَ أن يقولَ : إنه يظهرُ في غداةِ يومٍ من حَوْكِ الغيثِ ونسجِه بالذي ترى العيونُ من بدائعِ الأنوار وغرائبِ الأزهارِ ما يتوهَّم منه أن الغيثَ كان في فِعْلِ ذلك وفي نَسْجهِ وحوكه حِقَباً من الدَّهر . فالحيلولة واقعةٌ على كَوْنِ زمانِ الحوك حقباً لا على كون ما فعَله الغيثُ حوكاً فاعرفه
ومما يدخلُ في ذلك ما حُكي عن الصاحبِ من أنه قالَ : كان الأستاذُ أبو الفضل يختارُ من شعرِ ابنِ الروميّ وينقطُ عليه قال : فدفع إليّ القصيدةَ التي أوّلها - الطويل - :
( أتحتَ ضُلوعي جمرةٌ تتوقَّدُ ... )
وقال : تأمَّلْها . فتأمّلتها فكان قد ترك خيرَ بيتٍ فيها وهو :
( بِجَهْلٍ كجَهْلِ السَّيفِ والسَّيفُ مُنْتَضَى ... وحِلْمٍ كحِلْمِ السَّيفِ والسَّيْفُ مُغْمَدٌ )
فقلتُ : لِمَ ترك الأستاذُ هذا البيت فقال : لعل القلمَ تجاوَزَه . قال : ثم رآني من بَعْد فاعتذرَ بعذرٍ كان شَرّاً من تركه قال : إنما تركتُه لأنه أعادَ السيفَ أربعَ مرات . قال
الصاحبُ : لو لم يُعِدْ أربعَ مراتٍ فقال :
( بجهلٍ كجهلِ السيف وهو مُنتضًى ... وحلمٍ كحلمِ السيفِ وهو مغمدُ )
لفسدَ البيت
والأمرُ كما قال الصاحب . والسّببُ في ذلك أنك إذا حَدَّثْتَ عن اسمٍ مضافٍ ثم أردتَ أن تذكُرَ المضافَ إليه فإِن البلاغةَ تقتضي أنْ تذكره باسمه الظاهر ولا تُضْمِرُه . وتفسيرُ هذا أن الذي هو الحَسَنُ الجميلُ أن تقولَ : " جاءني غلامُ زيدٍ وزيدٌ " ويقبحُ أن تقول : " جاءني غلامٌ زيدٍ وهو " . ومن الشاهد في ذلك قول دِعْبِل - البسيط - :
( أضيافُ عِمرانَ في خِصْبٍ وفي سَعَةٍ ... وفي حِباءٍ غيرِ مَمنوعِ )
( وضيفُ عمرٍو وعمرٌو يسهرانِ معاً ... عمرٌو لِبِطنَتِهِ والضيفُ للجوعِ )
وقولُ الآخَر - الطويل - :
( وإنْ طُرَّةٌ راقَتْكَ فانظُرْ فربَّما ... أمرٌ مذاقُ العودِ والعُودُ أخضرُ )
وقولُ المتنبي - الطويل - :
( بمنَ نَضْرِبُ الأمثالَ أمْ مَنْ نَقيسُهُ ... إليك وأهلُ الدّهْرِ دونَكَ والدَّهرُ )
ليس بخفيٍّ على مَنْ لَهُ ذوقٌ أنه لو أتى موضعُ الظاهر في ذلك كلّه بالضمير فقيل : وضيفُ عمرٍو وهو يسهران معاً وربما أمرَّ مذاق العُودِ وهو أخضرُ وأهل الدهر دونَكَ وهو لعُدم حسنٌ ومزية لا خفاءَ بأمرِهما . ليس لأن الشعرَ يَنْكَسِرُ ولكن تنكرهُ النفس . وقد يرى في بادىءِ الرأي أنَّ ذلك من أَجْل اللَّبس وأنك إذا قلتَ : جاءني غلامُ زيدٍ وهو كان الذي يقع في نفسِ السامعِ أنَّ الضميرَ للغلام وأَنَّك على أنْ تجيءَ له بخبر إلاّ أنه لا
يستمرُّ من حيثُ إنَّا نقول : جاءني غلمانُ زيدٍ وهو فتجد الاستنكارَ ونُبوَّ النَّفْس مع أنْ لا لبسَ مثل الذي وجدناه . وإذا كان كذلك وَجَبَ أن يكونَ السببُ غير ذلك والذي يوجبِهُ التأمُّلُ أن يُرَدَّ إلى الأصل الذي ذَكَره الجاحِظُ من أنَّ سائلاً سألَ عن قولِ قيسِ بنِ خارجة " عندي قِرى كلِّ نازل ورضَى كلِّ ساخِط وخُطبةٌ من لَدُنْ تطلعُ الشَّمْسُ إلى أن تَغْرُبَ آمرُ فيها بالتَّواصُل وأَنهى فيها عن التقاطُع " . فقال : أليسَ الأمرُ بالصِّلة هو النهيُ عن التقاطعِ قال : فقال أبو يعقوب : أما علمتَ أن الكنايةَ والتعريضَ لا يعملانِ في العقول عملَ الإِفصاحِ والتكشيفوذكرتُ هناك أن لهذا الذي ذكر من أنَّ للتصريحِ عملاً لا يكونُ مثلَ ذلك العمل للكناية كان لإِعادةِ اللفظ في قولهِ تعالى : ( وبالحقِّ أنزلناهُ وبالحقِّ نَزَلَ ) وقولِه : ( قُل هوَ اللهُ أحدٌ اللهُ الصَّمَدُ ) عَمَل لولاها لم يكن . وإِذا كان هذا ثابتاً معلوماً فهو حكمُ مسألتنا . ومن البيِّن الجليِّ في هذا المعنى - وهو كبيتِ ابن الرومي سواءٌ لأنّه تشبيهٌ مثلهُ - بيتُ الحماسة - الهزج - :
( شَدَدْنا شَدَّةَ اللَّيثِ ... غدا والليثُ غضبانُ )
ومن الباب قول النّابغة - الرجز - :
( نَفْسُ عصامٍ سوَّدَتْ عِصاماً ... وعلَّمتْهُ الكَرَّ والإِقداما )
لا يخفَى على من له ذوقٌ حسنٌ هذا الإِظهارُ وأن له موقعاً في النفس وباعثاً للأَرْيَحيةِ لا يكون إِذا قيل : نفسُ عصام سَوَّدته شيءٌ منه البتة