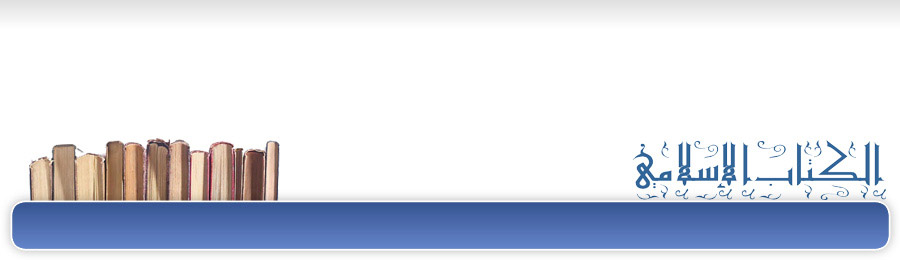كتاب : أخلاق الوزيرين
المؤلف : أبو حيان التوحيدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله الطيبين.أمتعك الله بنعمته عليك، وتولاّك بحسن معونته لك؛ وألهمك حمده، وأوزعك شكره، ومنحك صنعه وتوفيقه؛ وألبسك عفوه وعافيته، وأوصل إليك رأفته، وصرف رغبتك إلى ما خلص عندك نفعه عاجلاً، وحلَّت لك ثمرته آجلاً؛ وعرفك ما في الغيبة والفرة من الهُجنة والشناعة؛ وما في إظهار العيب والتنديد من العار والتباعة، وما في الإعراض عن أعراض الناس من السلامة والفائدة، وما في مباقاتهم ومقاربتهم والتوقير لهم من الراحة والعائدة، حتى لا تأتي ما تأتي إلاّ وأنت واثق بعاقبته ومرجوعه، ولا تدع ما تدع إلا وأنت محسوم الطمع من خيره ومردوده، وحتى لا تتكلف إلا ما في وُسعك وطاقتك، ولا تُكلّف أحداً إلا ما له طريق إلى طاعتك وإجابتك، وعنده الحجة القوية في تقديم أمرك، والتلوِّي فيما يتحمّله لك ويتوخّى فيه مسرّتك، ويقصد به جَذَلك وغبطتك، ويصير بالصبر عليه من أوليائك وشيعتك، ولا يخرج معه إلى محادّتك ومخالفتك، لآمر يُعوز، وحادث يعرض، وعطنٍ يضيق، وبالٍ ينخزل، وطباعٍ تخور، وحاسد يطعن، وعدوّ يعترض، وجاهلٍ يتعجرف، وسفيه يتهانف، وصدرٍ يحرج، ولسانٍ يتلجلج؛ بل يتلقى أمرك بالقبول، وينشط لخدمتك بالتأميل ويرى أن ما يناله من رضاك فوق ما يبذل فيه جهده لك، وما يحرزه من ثوابك أضعاف ما يبرزه من كدحه عندك، وما ينجو به من عتبكواستزادتكيوفي على ما يتعلق بسعيه في مرادك، وما يعزّ به الثاني من إحمادك أردّ عليه مما يذل به في الأول من اقتراحك، وما يقوى به من اليقين والطمأنينة في كرامته عندك أكثر مما يضعف به من الترنّح والشك في بواره عليك.
وهذا باب يرجع إلى معرفة الأحوال إذا وردت مشتبهة مستبهمة، وعواقب الأمور إذا صدرت مستنيرة متوضّحة؛ وثمرة هذه المعرفة السّلامة في الدنيا والكرامة في الآخرة، وبهذه المعرفة يصحّ الصرف والموازنة، وتمييز ما اختُلف فيه مما اتُّفق عليه، وما ترجّح بين الاختلاف والاتفاق، ولم يقم عند الامتحان والنظر على ساق.
وهذه حال لا تستفاد إلا بقلة الرضا عن النفس، وترك الهُويني في التشاور والتخاير، ومُجانبة الوِكال كيف دار الأمر وأين بلغت الغاية.
وأنت - حفظك الله - إذا نظرت إلى الدنيا وجدتها قائمة على هذه الأركان، جاريةً على هذه الأصول، ثابتة على هذه العادة؛ فكلّ من كان نصيبه من الكيس والحزامة أكثر، كان قسطه من النفع والعائدة أوفر، وكل من كان حظّه من العقل والتأييد أنزر، كانت تجارته فيها أخسر، وعاقبته منها أعسر.
وهذا الباب جماع المنافع والمضار، وبه يقع التفاوت بين الأخيار والأشرار، وبين السّفلة وذوي الأقدار؛ وهو باب ينتظم الصّدق والكذب في القول، والخير والشرّ في الفعل، والحق والباطل في الاعتقاد، والعدل والجور فيما عمّ، والإخلاص واليقين فيما خصّ، والراحة والسلوان فيما بان ووضح، والقناعة والصبر فيما نأى ونزح؛ ومتى تمّت هذه المعرفة، واستحكمت هذه البصيرة، كان الإقدام على ثقةٍ بالظفر، والنكُّول عن اطلاع على الغيب.
وهذه معانٍ من أبصرها نقدها، ومن نقدها أخذ بها وأعطى، وكان فيها أنفذ من غيره وأمضى؛ وهناك يُحكم لبُعده بالغَوْر، ولصدره بالسعة، ولصيته بالطّيرورة، ولطباعه بالكرم، ولخلقه بالسهولة ولعوده بالصلابة، ولنفسه بالمُداراة، ولوجهه بالطّلاقة، ولبشاشته بالخلابة. ومتى عاشرت من هذا نعتُه وحديثُه نعِمْتَ معه، وسلِمْتَ عليه، وسعِدت به، وكرُمت لديه، وكان حظُّك من خلالته ومجاورته الغبطة به، والغنيمة بمكانه؛ وأنّى لك بمن هذا وصْفُه وخبره، ومَن لك بالمرء الذي لا بَعدَه، مع اضطراب دعائم الدُّنيا، وتساقط أركان الدين؟ والأول يقول:
وكيفَ التماسُ الدَّر والضَّرعُ يابسُ
وما لامرئٍ ممّا قضَى اللهُ مَزْحَلُ
وليسَ لرحلٍ حطَّهُ اللهُ حاملُ
إنّ البريءَ من الهَناتِ سعيدُ
وما خَيرُ سيَفٍ لم يُؤَبّد بقائمِ
تسلُّ ولكنْ أَينَ بالسَّيفِ ضاربُ
الله يَرزُقُ لا كَيْسٌ ولا حَمَقُ
والبَرُّ خيْرُ حقِيبَقةِ الرَّجُلِ
ولقد أجاد المخزوميّ أبو سعد في قوله:
اصطلحَ السائلُ والمسؤولُ ... ليسَ إلى مَكْرُمةٍ سبيلُ
غالَ بإِخوانِ الوَفاءِ غُولُ ... كلُّ امرئٍ بشأْنِهِ مشغُولُ
وما أبعد الآخر حين يقول:
أَرى الناسَ شَتّى في النِّجارِ وإِن غَدَت ... خلائقُهم في اللُّؤْمِ
واحدةَ النَّجْرِ
وقد زادَني عَتباً عَلَى الدّهر أنّني ... عَدِمتُ الذي يُعدِي عَلَى
حادِث الدَّهر
وهذا كثير، والدّاءُ فيه متفاقم، والقول عليه مُعادٌ مَمْلول.
فإن قلت: هؤلاء شعراء، والشعراء سفهاء، ليسوا علماء ولا حكماء، وإنما
يقولون ما يقولون، والجشع بادٍ منهم، والطمع غالب عليهم، وعلى قدر الرّغبة
والرّهبة يكون صوابهم وخطأهم؛ ومن أمكن أن يُزحزَح عن الحقّ بأدنى طمع،
ويُحمَل على الباطل بأيسرِ رغبة، فليس ممَّن يكون لقوله إِتاء، أو لحكمته
مَضَاء، أو لقدَرِه رِفْعة، أو في خُلُقه طهارة؛ ولهذا قال القائل:
لا تَصحبنَّ شاعراً فإِنّه ... يَهجوك مَجّاناً ويُطْرِي بثمَنْ
وهذا لأنه مع الريح، إن مالت به مال، يتطوّح مع أقلّ عارض، ويُجيب أوّل
ناعق، ويَشيم أيَّ برقٍ لاح، ولا يُبالي في أي وادٍ طاح؛ فقد جمعَ دينه
ومروئته في قَرَنٍ تهاوناً بهما، وعجزاً عن تدبيرهما؛ فهو لا يكترث كيف
أجابَ سائلاً، وكيف أبطلَ مُجيباً، وكيف ذمّ كاذباً ومتحاملاً، وكيف مدحَ
مُوارِباً ومُخاتلا. فلا تفعل، فداك عمُّك، وشبّ ابنك، فإنّ رسول الله صلى
الله عليه وسلّم قد قال: " إنّ من الشِّعرِ لَحُكما " ، كما قال: " وإنَّ
من البيانِ لَسِحْرا " ، وكيف لا يكون كذلك وفيه مثل قول لبيد:
إن تَقوى ربِّنا خيرُ نَفَل ... وبإِذنِ الله رَيْثِي وعَجَلْ
والشعر كلام وإن كان من قبيل النظم، كما أن الخطبة كلام وإن كان من قبيل
النثر، والانتثار والانتظام صورتان للكلام في السَّمع، كما أن الحقّ
والباطل صورتان للمعنى، وكذلك المثل في السمع، وليس الصواب مقصوراً على
النّثر دون النظم، ولا الحقّ مقبولاً بالنّظم دون النّثر؛ وما رأينا أحداً
أغضى على باطل النّظم واعترض على حق النّثر؛ لأنّ النّثر لا ينتقص من
الحقّ شيئاً؛ وما أحسنَ ما قال القائل:
وإنّما الشعرُ لبُّ المرء يَعرِضُه ... عَلَى المجالس إن كَيْساً وإن
حَمَقَا
وإنّ أَشعَرَ بيتٍ أنت قائلُه ... بيتٌ يُقال، إذا أَنشدتَه، صَدَقا
وهذا باب لا يفيد الإغراق فيه إلاّ ما يُفيد التّوسط والقصد، فلا وجه مع
هذا للإطالة، ولَما يكون سبباً للملامة.
وهذه الجملة - أكرمك الله - أنت أحوجتني إليها، وجشَّمتني صعبها حتى
نَشبتُ بها قائماً وقاعداً، وتقلّبتُ في حافاتها مختاراً ومضطراً،
وتصرّفتُ في فنونها مُحسناً ومُسيئاً، لما تابعت إليّ من كتابٍ بعد كتاب،
تُطالبني في جميعه بنسخ أشياء من حديث ابن عبّاد وابن العميد وغيرهما ممّن
أدركتُ في عصري من هؤلاء، منذ سنة خمسين وثلاثمائة إلى هذه الغاية، وزعمتَ
أني قد خَبَرتُ هذين الرجلين من غمار الباقين، ووقفتُ على شأنهما،
واستبنتُ دخائلهما، وعرفتُ خوافي أحوالهما، وغرائب مذاهبهما وأخلاقهما.
ولَعمري قد كان أكثر ذاك، إما بالمشاهدة والصُّحبة، وإما بالسماع والرواية
من البطانة والحاشية والنُّدماء وذوي المُلابسة.
وقلت: ينبغي أن تُضيف إلى ذلك ما يتعلّق به، ويدخل في طرازه ولا يخرج عن
الإفادة بذكره، والاستفادة من نشره؛ فإن ذلك يأتي على كل ما تتوق إليه
النفس من كرم ولؤم، وزيادةٍ ونقص، وورع وانسلاخ، ورزانة وسُخف، وكَيْس
وبَلَه، وشجاعة وجُبن، ووفاء وغدر، وسياسة وإهمال، واستعفاف ونطْف، ودهاء
وغَفْلة، وبيانٍ ووعيّ، ورشادٍ وغيّ، وخطإٍ وصواب، وحِلْم وسفَه، وخلاعة
وتمالُك، ونَزاهة ودَنَس، وفظاظة ورقّة، وحياء وقِحَة، ورحمة وقسوة.
وقلتَ: ولا يحلو موقع ذلك كله ولا يعذُب ورده، ولا يغزر عدُّه، ولا ينقاد
السمع له، ولا يَراح القلبَ به إلا بعد أن تَدع المحاشاة وأنت مُقتدر،
وتفارق المخاشاة وأنت مُنتصر، وإلا بعد أن تترك العدوَ والحاسد ينقدّان
بغيظهما انقدادا، ويرتدّان على أعقابهما ارتدادا؛ فإنّ التَّقية في هذا
الفنّ مَجْزعة مضْرعة، وركوب الرّدع فيه مأْثرة ومَفخَرة.
وقلتَ والعامة تقول: من جعل نفسه شاةً دقَّ عنقه الذئب، ومن صيّر
نفسه نُخالةً أكله الدجاج، ومن نام على قارعة الطريق دقّته الحوافر دقّا،
والكِبرُ في استيفاء الحق من غير ظلم، كالتواضع في أداء الحق من غير ذُلّ،
وكما أن المنع في موضع الإعطاء حِرمان، كذلك الإعطاء في موضع المنع خذلان؛
وكما أن الكلام في موضع الصمت فضلٌ وهدر، كذلك السكوت في موضع الكلام
لكنةٌ وحَصر، وكما أن القلوب جُبِلت على حُبّ من أحسن إليها، كذلك النفوس
طُبعت على بُغضِ من أساء إليها؛ والجَبْلُ والطّبع وإن افترقا في اللفظ
فإنهما يجتمعان في المعنى، وكما أن الحب نتيجة الإحسان، كذلك البغض نتيجة
الإساءة، وكما أن المُنعم عليه لا يتهنّأ بنعمته الواصلة إليه إلا
بالشُّكر لواهبها، كذلك المُساء إليه لا يجد بَرْدَ غُلَّته ولذّة حياته
إلا بأن يشكو صاحب الإساءة، وإلا بأن يهجو المانع، ويذمّ المقصّر، ويثلُب
الحارم ويُنادي على الخسيس الساقط، والنّذل الهابط، في كلّ سوق، وفي كل
مجلس، وعند كل هزلٍ وجدّ، ومع كل شكل وضدّ؛ ميزانٌ عدْل، ووزنٌ بقسطٍ،
ونصفة مقبولة، وعادةٌ جارية على وجه الدَّهر.
وقلتَ: ومَن وجع قلبه وجَعك، وألم علّته ألمك؛ وحُرم حرمانك، وخُيّب
خيبتك، وجُرّع ما جُرّعته، وقُصد بما قصدت به، وعومِل بما شاع لك، قال
وأطال، وكرّر وسيّر، وأعادَ وأبدى، وعرَّض وصرَّح، ومرَّض وصحّح، وقام
وقعد، وقرّب وبعّد؛ وإنّ عيناً ترقد على الضّيم للعمى أحسن بها، وإن نفساً
تقِرُّ على الخَسْف للموت أولى بها من حياتها.
وقلت: أما سمعت قول العاتب على ابن العميد في رسالته حين قال الحقّ له؟
قال: وليعلم المرءُ - وإن عزّ سلطانه، وعلا مكانه، وكثُرت حاشيته وغاشيته،
وملَك الأعِنّة، وقاد الأزمَّة - أنه يُنْعَم له في الحمد على الحسن،
والذم على القبيح، وأن المخوف يرتاب من ورائه كما يقرَّع المأمون في وجهه،
فأعلاهما حالاً أكثرهما عند التقصير وبالا.
وهذا بابٌ يعرفه من الناس مَن ساسَ الناس؛ وهذا الكاتب يُعرف بالأشَلّ.
وقلتَ أيضاً: ولست أسألك أن لا تذكر من حديثهما إلا ما كان جالباً
لمقتهما، وداعياً إلى الزِّراية عليهما، وباعثاً على سوء القول والاعتقاد
فيهما، بل تُضيف إلى ذلك ما قد شاع لهما وشُهر عنهما، من فضائل لم
يَثْلُثهما فيها أحد في زمانهما، ولا كثير ممن تقدّمهما؛ فإنّ الفائدة
المطلوبة في أمرهما وشرْح حديثهما، تأديب النفس واجتلاب الأنس، وإصلاح
الخلق، وتخليص ما حُسن مما قبُح، وتسليط النظر الصحيح، مع العدل المحمود
فيما أشكل واشتبه بين الحسن المطلق والقبيح المطلق، وقلتَ: ومما ينبغي أن
لا تُغفله ولا تَذهب عنه، وتطالب نفسك بالتيقُّظ فيه، والتَّجمع له: باب
اللفظ والمعنى في الصدق والكذب، فإنّك إن حرّفت في هذا بعض التحريف، أو
جزَّفت في ذاك بعض التجزيف، خرج معناك من أن يكون فخماً نبيلاً، ولفظُك من
أن يكون حُلواً مقبولاً، لأنّ الأحوال كلها - في اصلاحها وفسادها - موضوعة
دون اللفظ المُونق، والتأليف المُعجِب، وقُبل فاسد معناه لصالح لفظه!
وقلتَ: وإنما نبّهتك على هذا شفقة عليك، وحرصاً على أن لا يكون لمُعْنتٍ
وعائبٍ طريق إليك، وأنت - بحمد الله - مُستوصٍ لا تُحوج إلى تنبيه بعنف،
وإن أحوجت إلى إذكار بلُطف؛ وقد كان البيان عزيزاً في وقت البيان،
والنُّصح غريباً في وقت النُّصح، والدّين مُسترَفاً في وقت الدين، إذ
الحكمة مُعانقةٌ بالصّدر والنحر، مُقبَّلة بكل شفةٍ وثغر، مخطوبة من جميع
الآفاق، يُقرع من أجلها كلُّ باب، ويَحرق على فائتها كلُّ ناب، والأدب
متنافس فيه، محروص على الاستكثار منه، مع شُعَبه الكثيرة وطرائقه
المختلفة؛ والدين في عرض ذلك مَذبوب عنه بالقول والعمل، مرجوع إليه
بالرِّضا والتسليم، مقنوع به في الغصب والحِلم؛ فكيف اليوم وقد استحالت
الحال عجماء، ومَلك الغنى والثّراء الرؤساء والعلماء، وقلّ الخائض فيما
كسبَ زيادةً أو نفى نقيصة، وأورث عزّاً أو أعقب فوزاً.
وقلت:
وليكُن ذلك كله - إذا نشِطت له - مقصوراً غير مبسوط، أو بين
المقصور والمبسوط، فإنه إن زاد على هذا التحديد طال، وإذا طال مُلّ، وإذا
مُلَّ نُظر إلى صحيحه بعين السّقيم، وحُكم على حقّه بلسان الباطل، وتُخيّل
القصدُ فيه إسرافاً، والعدلُ فيه جورا، وعند ذلك يحول عن بهجته ومائه،
ورونقه وصفائه.
وجميع ما قلته - حاطك الله - وأتيت به، وسحبت ذيلك عليه، ورفلْت أعطافك
فيه، قد سمعته وفهمته، وطويته في نفسي وبَسَطته، وجمعته بذهني وفرّقته،
ونظمتُه عندي ونثرته؛ ولست جاهلاً به ولا ذاهلاً عنه، ولكن من لي بعتاد
ذلك كله، وبالتأتّي له، وبالقدرة عليه، وبالسّلامة فيه إن فاتتني الغنيمة
فيه؟ مع صدري الضيّق، وبالي المشغول ومع رُزوح الحال، وفقد النّصر، وسوء
الجزع، وضَعف التوكّل؛ نعم!، ومع الأدب المدخول، واللسان المُلجلَج،
والعلم القليل، والبيان النّزر، والخوف المانع؛ وإنّي لأظنّ أن الطائع لك
في هذه الخطة، والمجيب عن هذه المسألة، قليل التقّية، سيّء البقية، ضعيف
البديهة والرويّة؛ لأنه يتصدّى لما لا يفي به، ولا يتسّع له، ولا يتمكّن
منه؛ فإن وفى واتسّع وتمكّن لم يسلم على كثير ممن يقرأ كلامه، ويتصفّح
أمره، ويقصّ أثره، ويطلب عثرته؛ لأنّ الناس في نشر المدح والذمّ، وفي بسط
العذر واللّوم؛على آراء مختلفة، ومذاهب متباينة، وأهواء مشتعلة، وعادات
مُتعانِدة.
على أنّهم، بعد شدّة جدالهم وطول مِرائهم، رجلان: متعصّب لمن تذُمّه
وتَعيبه وتَنثُّ القبيح عنه، فهو يغتفر له جميع ما يسمع منك، صادقاً كنت
أو كاذباً، مُعرّضاً كنت أو مفصحاً.
أو مُتعصّب على من تمدحه وتُزكّيه وتُفضله وتُثني عليه، فهو يرُدّ عليك
كلّ ما تدّعيه، مُحققاً كنت أو مُجزِّفاً، موضِّحاً كنتَ أو مُزخرفاً؛
ولذلك قال بعض علماء السلف الصالح: هما أمران مَثواك بينهما، راضٍ عنك فهو
يمنحك أكثر مما هو لك، وساخطٌ عليك يتنقّصك من حقّك؛ فرُمَّ ما ثلَم
الباغي بفضلة الراضي يعتدل بك الأمر؛ والشاعر قد فرغ من هذا المعنى وسيّره
في قريضه المشهور المتداول حيث يقول:
وعينُ الرّضَا عن كل عيب كليلةٌ ... ولكنّ عينَ السُخط تُبدِي المساويا
على أن هذا الشاعر قد أثبت العيب وإن كان قد وصفه بكلول العين عنه، ودلّ
على المَساوي وإن كان السُّخط مُبديها، وهذا لأنّ الهَوى مُقيم لابثٌ
والرأي مجتاز عارض، ولا بدّ للهوى من أن يعمل عمله، ويبلغ مبلغه، وله قرار
لا يطمئن دونه، وحدّ هو أبداً يتعدّاه ويتجاوزه، وله غُول تُضِلّ، وتمساحُ
يبتلع، وثعبان - إذا نفخ - لا يُبقي ولا يذر، والرأي عنده غريب خامل،
وناصحٌ مجهول.
وقال بعض الحكماء: فضل ما بين الرأي والهوى أن الهوَى يخُصُّ والرأي يعمّ،
والهَوى في حيّز العاجل، والرأي في حيِّز الآجل، والرأي يبقى على الدّهر،
والهَوى سريع البيُود كالزّهر، والرأي من وراء حِجاب، والهَوى مُفتّح
الأبواب ممدَّد الأطناب؛ ولذلك قال أيضاً بعض العرب، ويُقال هو عامر بن
الظَّرِب: الرأيُ نائمٌ والهَوى يَقظان، فأرقِدوا الهوى بفظاظة، وأيقظوا
الرأي بلطافة.
وقال الشاعر:
كم من أسير في يَدَي شَهواتِهِ ... طفِر الهَوى منهُ بحَزْم ضائِع
وقال أعرابي: لم أرَ كالعقل صديقاً معقُوقاً، ولا كالهوى عدوّاً معشوقاً؛
ومن وفَّقه الله للخير جعل هواه مقْموعاً، ورأيه مرفوعاً.
وإذا كان الهوى - أبقاك الله - على ما وَصَفنا، وعلى وراء ما
وصفنا مما لا نُحيط به وإن أطلنا، فمتى يخلو المادح - إذا مدح - من بعض
الإفراط تقرُّباً إلى مأموله، وخِلابةً لعقله، واستدراراً لكرمه، وبَعْثاً
على تنويله وتخويله؛ وهذه حال مصحوبة في الممدوح إذا كان أيضاً غائباً أو
ميتاً؟ أو متى يسلَم الذامُّ - إذا ذمّ - من بعض الإسراف تعنُّتاً لصاحبه
وحملاً عليه بالإنحاء الشديد، والقول الشنيع، والنّداء الفاضح، والحديث
المُخزي، وجرياً مع شفاء الغيظ وبرد الغليل؟ لأن جرعة الحرمان أمرّ من
جرعة الثكل، وضياع التأميل أمضّ من الموت، وخدمة مَن لم يجعله الله لها
أهلاً أشدُّ من الفقر، وإنما يُخدم من انتصب خليفة لله بين عباده بالكرم
والرحمة، والتجاوز والصّفح، والجُود والنائل، وصلة العيش وبذل مادة الحياة
وما يُصاب به روح الكفاية؛ وحرمان المؤمّل من الرئيس ككُفران النعمة من
التّابع ورحَى الحَرْب في هذا الموضع راكدة، والقراعُ عليه قائم، والخطابة
في دفعه وإثباته واسعة، والتَّمويه مع ذلك مُعترض، والإعتذار مردود،
والتأويل كثير، والتَّنزيل قليل.
ولقد رأيت الجَرجائيّ - وكان في عِداد الوزراء وجلّة الرؤساء، وإنما قتله
ابن بقية لأنه نُعم له بالوزارة - يقول للحاتميّ أبي عليٍ، وهو من أدهياء
الناس:
إنما تُحرَمُ لأَنك تَشْتُمُ
فقال الحاتميُّ: وإنما أشتم لأني أُحرم.
فأعاد الجَرْجائي قوله.
فأعاد الحاتمي جوابه.
فقال ثم ماذا؟ قال الحاتمي: دع الدّست قائمة، وإن شئت عملناها على الواضحة.
قال: قُل! قال الحاتمي: يقطع هذا أن لا يسمعوا مدائحهم، ولا يكترثوا
بمراتبهم؛ وأن يعترفوا لنا بمزية الأدب وفضل العلم وشرف الحِكمة، كما
خَذِينا لهم بعظمة الولاية، وفضل العمل، وبَسْط اليد، وعرض الجاه،
والاستبداد بالتنَعُّم والطّاق والرِّواق، والأمر والنهي، والحجاب
والبوّاب؛ وأن يكتبوا على أبواب دُورهم وقُصورهم: يا بني الرجاء! ابعدوا
عنّا، ويا أصحاب الأمل! اقطعوا أطماعكم عن خيرنا ومَيْرِنا، وأحْمرنا
وأصفرنا، ووفِّروا علينا أموالنا، فلسنا نرتاح انثركم في رسالة
تُحبِّرونها، ولا لنظمكم في قصيدة تتخيَّرونها، ولا نَعتدُّ بملازمتكم
لمجالسنا، وتردُّدكم إلى أبوابنا، وصبْركم على ذُلّ حجابنا، ولا نَهَشُّ
لمدحكم وقريضكم، ولا لثنائكم وتقريظكم؛ ومن فَعَل ما زَجرناه عنه ثم نَدِم
فلا يلومنَّ إلا نفسه، ولا يقلعنّ إلا ضرسه، ولا يخمشنّ إلا وجهه، ولا
يشُقّنّ إلا ثوبه، وإنّ من طمع في موائدنا يجب أن يصبر على أوابدنا، ومن
رغب في فوائدنا نَشِبَ في مكايدنا. فأما إذا استخدمونا في مجالسهم بوصْف
محاسنهم، وستر مساويهم، والاحتِجاج عنهم، والكذب لهم؛ وأن نكون ألسِنةً
نفّاحةً عنهم فليُثيبوا على العمل، فإنَّ في توفيَّة العُمّال أُجورهم
قوام الدنيا، وحياة الأحياء والموتى؛ فإن قصَّرنا بعد ذلك في إعادة الشكر
وإبدائه، وتنميق الثّناء وإفشائه، فإنّهم من مَنْعنا في حلّ، ومن الإساءة
إلينا في سعة.
فرأيت الجرجائي - حين سمع هذا الكلام النَّقي، وهذه الحجة البالغة - وَجَم
ساعةً ثم قال: لَعَمري إذا جئنا إلى الحقّ، ونظرنا فيه بعين لا قَذَى بها،
ونفسٍ لا لؤم فيها، فإن العطاء أولى من المنْع، والتنويل أولى من الحرمان،
والخطأ في الجُود أسلم من الصواب في البُخل، لأن الصواب في البخل خفيّ
جداً، وقلَّ من يعرفه، والخطأ في الجود حُلو جداً، وقلّ من يكرهه.
وأنا أقول: قد صدق هذا الرجل الجليل في هذا الحرف صِدقاً لا تماريَ فيه.
ولقد جرى بيني وبين أبي عليّ مسْكُوَيه شيءٌ هذا موضعه.
قال مرّة: أما ترى إلى خطأ صاحبنا - وهو يعني ابن العميد - في إعطائه
فلاناً ألف دينار ضربةً واحدة؟ لقد أضاع هذا المال الخطير فيمن لا يستحق.
فقلت له - بعد ما أطال الحديث وتقطّع بالأسف: أيها الشيخ! أسألك
عن شيء واحد واصْدُق، فإنّه لا مَدَبّ للكذِب بيني وبينك، ولا هبوب لريح
التمويه علينا؛ لو غلط صاحبك فيك بهذا العَطاء وبأضعافه وأضعاف أضعافه، أَ
كنتَ تتخيّله في نفسك مُخطئاً ومُبذّراً ومفسداً وجاهلاً بحق المال؟ أو
كنت تقول: ما أحسن ما فعل! ولَيْته أربى عليه؟ فإن كان ما تسمع على
حقيقته، فاعلم أن الذي بدّد مالك، وردَّد مقالك إنما هو الحسد أو شيء آخر
من جنسه، فأنت تدَّعي الحِكمة، وتتكلم في الأخلاق وتُزيّف منها الزائف،
وتختار منها المُختار. فافطن لأمرك، واطّلع على سرّك وشرك.
هذا ذكرته - أبقاك الله - لتتبين أن الخطأ في العطاء مقبول، والنَّفس
تُغضي عليه، والصّواب في المنع مردود، والنفس تقلق منه؛ ولذلك قال المأمون
وهو سيّد كريم، وملك عظيم، وسائس معروف: " لأَن أُخطِئَ باذِلاً أَحبُّ
إِليَّ من أن أُصيبَ مانعاً " ، والشاعر يقول:
لا يَذْهب العُرْفُ بينَ اللهِ والنّاسِ
وإن كان يكفر النعمة بعض من أُنعم عليه بها، إنه ليشكرها كثير ممن لم
يتلمَّظ حلاوتها، ولم يَطْعم فُتاتةً منها، ولم يُسِغ جَرْعةً من غديرها،
ولم يَسْحب ذيلاً من أذيالها.
وصدر هذا الكلام شبيه بشيء لا بأس بروايته في هذا الموضع وإن لم يكن من
قبيل ما طال القول فيه، وتوالى النَّفَسُ به.
قال المأمون لأبي العتاهية: إذا قال الله لعبده: لِمَ لم تُطعني، أي شيء
يكون من جوابه؟ فقال: يقول: يا ربِّ لو وفَّقتني لأطعتك.
قال: فإن الله يقول: لو أطعتني لوفَّقتُك.
قال أبو العتاهية: فإن العبد يقول: لو وفقتني لأطعتك، أيكون ما يحتاج إليه
العبد نَسيئةً، وما يُطالبه الله به نقّداً؟ قال المأمون: فما يقطع هذا؟
قال يا أمير المؤمنين، اضرب عنه، فإنّ الدَّست قائمة.
وأرجعُ فأقول: وما خلا الناس منذ قامت الدنيا من تقصير واجتهاد، وبلوغ
الغاية، وقصور عن النهاية، وتَشارُك في المحامد والمَذامّ، والمساوي
والمحاسن، والمناقب والمثالب، والفضائل والرذائل، والمكارم والملائم،
والمنافع والمضارّ، والمَكاره والمسارّ؛ ومن بعض ما يكون للقائل فيه
مَنْدوحه، وللشَّاغب به استراحة، وللنّاظر فيه مُتّسع، وللسّامع فيه
مُستَمْتع؛ وأحسنهم حالاً، وأسعدهم جَدّاً، وأبلغهم يُمناً، وأربحهم
بضاعة، من كانت محاسنه غامرة لمساويه، ومناقبه ظاهرة على مثالبه، ومادحه
أكثر من هاجيه، وعاذره أنطق من عاذله، والمحتَجُّ عنه أنبَهُ من المحتجِّ
عليه، والنَّافحُ عنه أصدق من النافح فيه؛ وليس العمل على عدد هذه وهذه،
ولكن على أن لا يكون مع صاحب المحاسن من الخِصال اللَّئيمة ما يَحْبِطُها
ويجْتاحُها، ويخْتلعها، ويأتي عليها وإنْ صغُر حجم تلك الخلّة،وخَمل اسم
تلك الخَصْلة؛ وأن يكون مع صاحب المساوي من الخلال الكريمة ما يغطّيها،
ويُسبل السّتر عليها، ويُعين الذَّائد عنها، ويُبيِّض وجهَ النَّاصر لها،
ويمدُّ باعَ المتطاول إليها؛ وكما وجدنا السيِّئات يَحبِطْن الحَسَنات،
كذلك وجدنا الحسنات يُذهِبن السيَّئّات.
والعمود الذي عليه المعوَّل، والغاية التي إليها المَوْئل، في خصالٍ ثلاثٍ
هُنَّ دعائم العالم، وأركان الحياة، وأُمهات الفضائل، وأُصول مصالح الخلق
في المعاش والمعاد؛ وهنَّ: الدّين، والخُلُق، والعِلْم، بهنَّ يعتدل
الحال، ويُنتهى إلى الكمال، وبِهنَّ تُمْلك الأزِمَّة، ويُنال أعزُّ ما
تسمو إليه الهِمّة؛ وبهنَّ تُؤمَن الغَوائل، وتُحمد العَواقب؛ لأنّ الدّين
جِماع المَراشد والمصالح، والخُلُق نظام الخيرات والمنافع، والعِلم رباطُ
الجميع؛ ولأنّ الدّين بالعلم يصحّ، والخلق بالعلم يَطْهُر، والعِلم بالعمل
يكمُل؛ فمَن سَلِم دينه من الشّك واللّحاء، وسُوء الظّنّ والمِراء، وثبت
على قاعدة التَّصديق بموادّ اليقين الذي أقرَّ به البُرهان، وطهُر خلُقُه
من دَنَس المَلال، ولَجاج الطَّمع، وهُجنة البُخل، وكان له من البشر نصيب،
ومن الطّلاقة حظ، ومن المُساهلة موضع؛ وحَظِي بالعلم الذي هو حياة الميّت،
وحَلْي الحيّ، وكمال الإنسان فقد برَّز بكل فضْل، وبان بكلّ شرف، وخلا عن
كل غباوة، وبَرِئَ من كلّ مَعَابة، وبلغَ النَّجد الأشرف، وصار إلى الغاية
القُصوى.
ولم أذكُر لك العقل في هذا التّفصيل، وهو أوّلهنّ، وبه يتمّ
آخرهنّ، وعليه مجرى جميع ما افْتَنَّ القول به؛ لأنه موهبة الله العُظمى،
ومِنحته الكبرى، وباب السّعادة في الآخرة والأولى، وكان ما عداه فرعاً
عليه، ومضموماً إليه؛ لأنه متى عَدِمه الإنسان الحيّ الناطق فقد سقطَ عنه
التكليف، وبَطَل عليه الاختيار، وصار كبعض البهائم العامِلة، وكبعض الشخوص
الماثِلة؛ وبه يُعرَف الدِّين، ويقوَّم الخلُق، ويُقتبس العلم، ويُلتمس
العمل الذي هو الزُّبدة؛ وقد يعدم العمل والعقل موجود، وقد يُفقد الخلق
والدين ثابت؛ فليسالأصل كالفرع، ولا الأول كالثاني، ولا العلّة كمجلوب
العِلة، ولا ما هو قائم كالجوهر، كما هو دائر كالعَرَض؛ فلهذا أضربتُ عن
ذكره، وغَنِيت عن الاستظهار به؛ وإذا تمَّت فائدة الكلام فما زادَ عليه
لغو، وإذا استقرَّ فيه المعنى فما أَلمَّ به فساد.
والناس - هَداك الله - من هذه الخصال التي ميّزتها والخلال التي نصَصْتُ
القول فيها، على أنصباء مختلفة، وهم فيها على غايات متنازحة، بالقلة
والكثرة، والضعف والقوّة، والنقصان والزيادة، ومن أجلها يُتوّخون بالحمد
على الإحسان، ويخدمون بالشكر على الجميل، ويُحيون بالنصائح الخالصة،
ويُحبُّون بالقلوب الصافية؛ ويُثنى عليهم بالقرائح النقيّة، والطّويات
المأمونة، ويُذب عنهم بالنيات الحسنة والألسنة الفصيحة ويُعاونون عند
الشدائد الحادثة، والنوائب الكارثة، والأمور الهائلة، والأسباب الغائلة،
بالمال المَدخور، والنُّصح المنخول، ويُدفع عنهم بالأيدي الباطِشة،
والأقدام الثابتة، والأرواح العزيزة، والأنفس الكريمة؛ وكذلك يُوكَسُون
على التّقصير باللاّئِمة، ويُجبهون على اللُّؤم بالآبدة؛ ويُذمّون على
التهاون بكل فاقرة، ويُطوَّقون كل خِزيٍ ومَعَرّة، ويواجهون بكل شنعاء
مُفْضِعة، ويُغتابون بكل فاحشة مُنكرة، ويُرمون بكل ساقطة ولاقطة،
ويُحرقون بكل نارٍ حامية، ويُقذفون بكل مُخجلة مُندِية.
فهذا جمهور الخَبَر عن حال المُحسن إذا أحسن، وحال المُسيء إذا قصّر، وهم
إذا كانوا على هذا السياق ثابتين، ولهذا المِنهاج سالكين، فإنهم يتنزَّعون
إلى أصول حديثة وقديمة، وأَعراق كريمة ولئيمة، والمجدود من بينهم مَن لاثَ
الله بيافوخه الخير، وعقد بناصيته البركة، وجعل يده ينبوع الإفضال
والجُود، وعصم طِباعه من الخساسة والدَّناءة، وكفاه عار البطالة والفسالة
ونزّهه عن الإسفاف والنَّذالة.
وهذا كله ثمرة البصيرة الثاقبة، والنيّة الحسنة، والضمير المأمون، والغيب
السّليم، والعقل المؤرب، والحق المؤثر وإن كان مُراً، والأدب الحسن وإن
كان شاقاً، والعفافة التي أصلها الطّهارة، والطّهارة التي أصلها النّزاهة؛
ومن عجَن الله طينته بهذا الماء، وروّح عنه بهذا الهواء، وأطلَق نفَسه
بهذا الجوّ، وقلبه على هذا البِساط، وسقاه بهذا النَّوء، فقد أيّده بروح
القدس، ووصله بلطيف الصُّنع، وأكمل عليه النّعمة الجليلة، وأنابه بالشرف
المحسود، وميَّزَه بالمزية التامّة، وخصّه بخيم الأنبياء، وألبسه جلباب
الأصفياء، وأتاهُ ضرائب الصالحين وأحضره توفيق المهديّين المرضيّين.
وقد صحّ - حفظك الله - عندي، ووضح لي أن الذي هاجك على هذا
المعنى حتى حرّكتَني له، وطالبتني به، ولم ترضَ منّي إلا بالمبالغة
والاستقصاء وإلا بمباداة الأعداء. وذَوي الشَّحناء: اجتماعنا في مجالس
العلماء، وتلاقينا على أبواب الحكماء والأدباء أيام كنت أُفَكِّهُك
بالحديث النادر، واللّفظ الحسن، فأُضحِك سنّك بما ملُح وحرّ، وأزيدك من
خلال ذلك كله خِبرة بالدّهر وأهله، واعتباراً بالزمان وتصرّفه، وأفتح عليك
باب المؤانسة، وأصف لك أخلاق الناس وما يفترقون به ويجتمعون عليه من غرائب
الأمور، وطرائف الأحوال أيام كان عود الشّباب رطيباً، وورق الحياة نضيراً،
وظِلّ العيش ممدوداً، ونجم الزمان مُتوقّداًومُقترح النَّفس مُواتياً،
وروض المُنى خضِلاً، ودَرُّ النّعمة متّصلاً، وداعي الهوى مُشمّراً؛ أيام
رأسك فَيِنان، وأنت كالصَّعدة تحت السِّنان، شطاطك معجب، وحديثك معشوق،
وقُربك مُتمنَّى، والليل بك قصير، والنهار عليك مقصور، والعيون إليك
طوامح، والعواذل دونك نوائح وذاك زمان مضى فانقضى، فأما غوياً وإما رشيدا؛
وكان الوقت يقتضي ذلك ويسعه، والحال تُواتيه وتحمله، والعُذر يقع لطالبه
وملتمسه؛ لكني إذا نظرت إلى أملي المتعلق بك، وطمعي الحائم عليك، ورجائي
المذبذب عليك حولك؛ وحالي التي جعلك الله كافلها وراعيها، وجامعها، وناظم
ما انتثر منها، ومُؤلِّف ما انتشر عنها - رأيت البدار إلى بُغيتك أدباً
محموداً، وحظاً مُدركاً، والتراخي عن طاعتك حرماناً حاضراً، وعتباً مؤلماً.
وهكذا صنيع الطَّمع؛ فقل لي ما أصنع إن ردّ اعتذاري من يَسُرّه عِثاري،
ويسُوءه استمراري؛ وليس إلاّ الصبر فإنه مفتاح كل باب مُرتج وبرود كل
حرّان ملهج، وما زال الطمع قديماً وحديثاً وبدءاً وعوداً يُضرع الخدّ
الصّقيل، ويُرغم الأنف الأشمّ، ويعفّر الوجه المفدّى، ويُغصن العارض
المَنّدى، ويحني القوام المهتزّ، ويُدنّس العِرض الطاهر؛ ولحا الله الفقر
فإنه جالب الطمع والطَّبَع، وكاسب الجشع والضَّرَع، وهو الحائل بين المرء
ودينه، وسدٌّ دون مروءته وأدبه،وعزّة نفسه؛ ولقد صدق الأول حيث قال:
وقد يَقْصر القُلُّ الفَتَى دونَ هَمِّه ... وقد كانَ لولاَ القُل طَلاّعَ
أَنجُدِ
وما كذب الآخر حيث يقول:
إِذ المرءُ لم يَقْنَ الحياءَ إذا رأَى ... مطامعَ نَيْل دنّسَتْه المطامعُ
إذا قَلَّ مالُ المرءُ قَلَّ صديقُه ... وأهوت علَيه بالعيوبِ الأَصابعُ
وأجاد الآخر حين قال:
أَزرى بنا أَننا شالَت نَعامتُنا ... والفقر يُزْري بأَحسَابٍ وأَلبابِ
وما أملح قول الأعرابي في قافيته:
ما بالُ أُمّ حُبيش لا تكلّمنا ... إِذا افْتَقَرنا وقد نُثْرِي فنتَّفِقُ
وصدق، لأنها إذا لحقته على الفقر رغبت عنه ولم تواصله، وفركته واختارت
عليه.
وما أحسن ما قال بعد هذا في وصف سيرته وحُسن عادة أهله، فإنه قال:
إِنّا إِذا حُطَمةٌ حَتّت لنا ورقاً ... نُمارِس العُودَ حتى يَنْبُت
الوَرَقُ
وصاحب الفقر إن مدح فرّط، وإن ذمّ أسقط، وإن عمل صالحاً أحبط، وإن ركب
شيئاً خلط وخبّط؛ ولم أر شيئاً أكشف لغطاء الأديب، ولا أنشف لماء وجهه،
ولا أذعر لسرب حياته منه، وإن الحُرّ الآنف، والكريم المتعيّف من مُقاساته
والتجلّد عليه، لفي شغل شاغل وموتٍ مائت.
وعلى ما قدّمت من هذه الكلمات، وأطلت به هذا الباب، فقد امتثلت أمرك
وسارعت إليه، وأرجو أن تهب لي فيه رضاك إن وقه موقعه الذي أمّلته، وتهديني
إلى الصواب إن زلَّ عن حدّك الذي حدّدته، وما غايةُ أملي به، وقُصارى
همّتي منه، إلاّ أن أكون سبباً قوياً فيما حاز لك الشكر منّي، وأوفر عليك
الحمد عنّي، وأذاقك حلاوة مدحي وتمجيدي، والشاعر يقول:
العُرف أَصلٌ يُجتَنَى ... مِن فرعِه الثَّمَر الحَمِيدْ
يَبلَى الفَتى في قَبرِه ... وفَعَاله غَضٌّ جَدِيدْ
وسأجعل قصدي نحو السّلامة إذا غلبني اليأس من الغنيمة، وأُضيف
إلى متن الحديث فوائد كثيرة، وأجتهد معذِراً، وأتقصّى معذوراً، وأحكم
متكرِّماً، وأقول ما أقول رائياً؛ وراوياً؛ على أني لا أثق بالخاطر إذا
طاش، ولا باللسان إذا هَمز، ولا بالقلم إذا استرسل، ولا بالهوى إذا اشتمل
وسَوَّل؛ فإن الهوى يعمي ويُصمّ، ولعلّ الغيظ يجْرح ويُجهز.
وهذه آفات متداركة لا سبيل إلى التغاضي عنها، والسّلامة عليها، وذاك لأن
الكلام في حمد من يُحمد، وذم من يُذم، إن نُمِّق تنميقاً دَخله التزَيُّد،
والمتزيّد مَقْليّ، وإن أُرسل على غراره شانه التّقصير، والمقصّر مُعجَّز؛
ولأنّ يدخله التقصير فيكون دليلاً على الإبقاء، أحبُّ إليّ من أن يدخله
التزيد فيكون دليلاً على الإرباء؛ على أنّ من وصف كريماً أطرب، ومن أطرب
طرِب، والطّرب خفّة وأريحية تستفزّان الطباع، وتُشبِّهان الحصيف بالسخيف؛
فأما من حدّث عن لئيم فإنّ أساس كلامه يكون على الغيظ، والغيظُ نارُ
القلب، وخبث اللسان، وتشنيع القلم، فكيف الإنصاف في وصف هذين الرجُلين على
هذين الحدّين، مع سَرف الهوى، ووقان الغيظ، وعادة الجوْر، وداعية الفساد،
وصارفة الصّلاح؟ وهذه أعراض لا محيص منها ولا أمان من اعترائها، ولا واقي
من تعاوُرها، وبعض هذا يهتك سِتر الحِلم وإن كان كثيفاً، ويفتق جيب
التجمُّل وإن كان مكفوفاً، ويُخرج إلى الجهل وإن كان يُقبّحه متقدّماً.
وكنتُ هممت ببعض هذا منذ زمان، فكبح عناني عن ذلك بعض أشياخنا وقصّر
إرادتي دونه، وزعم أنّ الاختيار الحسن، والأدب المرضيّ ينهيان عنه، ولا
يُجوِّزان الخوض فيه؛ لأنّ الغيبة والقذع والعَضِيهة والتَّقيح والسّبّ
المؤلم والكلام القاشر، والمكاشفة بالملامة والشتيمة بلا مراقبة ليست من
أخلاق أهل الحِكمة، ولا من دأب ذوي الأخلاق الكريمة، وقد قال بعض الحكماء:
لا تكوننّ الأرض أكتم منا للسرّ؛ ومن اعتاد الوقيعة في الأعراض، ومُباداة
الناس بالسّفه، وثَلبهم بكل ما جاش في الصدر، وتذرَّع به اللسان، فليس ممن
يُذكر بخير، أو يُرجى له فلاح، أو يُؤمَنَ معه عيب؛ قال: وهل الحلم إلاّ
في كظم الغيظ، وفي تجرّع المضض، وفي الصبر على المرارة، وفي الإغضاء عن
الهفوات؛ ومن لك بالمهذّب النّدب الذي لا يجد العيب إليه مُختطى، والأول
يقول:
ولست بمُسْتَبقٍ أَخاً لا تَلُمُّه ... عَلى شَعَثٍ أَيُّ الرجالِ
المهذَّبُ
وقيل: لو تكاشفتم ما تدافنتم، ولو تساويتم ما تطاوعتم؛ ولا بدّ من هَنَةٍ
تُغتفر، ومن تقصيرٍ يُحتمل، والاستقصاء فُرقة، وفي المُسالمة تَحبُّب، ومن
ناقش في الحساب فقد رغِب عن سجاحه الخُلُق، وحُسن المَلَكة وإيثار الكَرَم.
وهذا الذي قاله هذا الشيخ الصالح مذهب معروف، وصاحبه حميد، لا يدفعه من له
مُسكةٌ من عقلٍ وسيرةٌ صالحة في الناس، وأدب موروث عن السّلف؛ وليت هذا
القائل وليَ من نفسه هذه الولاية، وعاملَ غيره بهذه الوصية، وليته بدأ
الكلام وما شابهه الرئيس الذي قد أخرج تابعه إلى هذا العناء والكد، وإلى
هذا القيام والقُعود! لا، ولكنه رأي جانب البائس المحروم أَليَن، وعَذْلَ
المنتَجع المظلوم أهوَن، وزجْر المتلذِّذ بما يَنُثُّه ويستريح به أسهل؛
فأقبل عليه واعظاً، وأعرض عن ظالمه مُحابياً.
وبعدُ فصاحب هذا القول وادع غير مُحفظ، وموفور غير منتقص، وناعم البال غير
مَغيظ، وصحيح الجناح غير مهيض؛ ولو شيكَ بحدّ قتادةٍ لكنّا نقف على عريكته
كيف تكون، وعلى شكيمته كيف تثبت، وكُنّا نعرف ما يأتمر عليه، وليس بَرْد
العافية من حرّ البلاد في شيء.
ولما وقعت الفتنة أيام المهلّب كان أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن
يُثبِّط الناس عن الوثوب مع بني المهلب في قتال أهل الشام، وقام بذلك
مقاوم شقَّت على مروان بن المهلّب، فقام مروان ذات يومٍ خطيباً، وحثّ
الناس على الجدّ والإنكماش، ثم عرّض بالحسن فقال: بلغني أن هذا الشيخ
الطّالح المُرائي يُثبّط الناس عن الطلب بحقّنا والله لو أنّ جاره نزَع من
خُصّ داره قصبة لظلّ أنفه راعفاً، ودمعه واكفاً، وقلبُه لاهفاً، ولسانه
قارفاً، ويُنكر علينا أن نطلب ما لنا، وكلاماً غير هذا غادرناه قادرين؛
لأنه لا وجه للإطالة به؛ ولا أقول إن مروان بن المهلّب، أحقّ بما قال من
الحسن، ولكن الحسن تكلّم على مذهب النُّسّاك، ومروان قابل ذلك بمذهب
الفُتَّاك.
وفي الجملة - أبقاك الله - ليس المضطر كالمختار، ولا المحرج كالسليم، ولا
الموفور كالموتور، ولا كل حكم يلزم المتوسط في حاله يلزم المتناهي في
حاله؛ ومتى كان - عافاك الله - التابع كالمتبوع، والآمل كالمأمول،
والمستميح كالمُنعم، والمغبوط كالمرحوم، والمُدرك، كالمحروم؛ هذا في
مُنقَطع الثَّرى، وذلك في قُلَّة المُزْن.
هذا عمرو بن بحر أبو عثمان، وهو واحد الدنيا، كتب رسالة طويلة في ذمّ
أخلاق محمد بن الجهم، ومدح أخلاق ابن أبي دُواد، وبالغ في الوصفين، وخطبَ
على الرَّحْلين، ولم يترك قبيحةً إلا أعلقها محمداً، ولا حسنة إلا منحها
أحمد، وحتى جعل ابن الجهم مع إبليس في نِصابٍ واحد، وابن أبي دواد مع
مَلَك في نِقاب واحد؛ وهكذا " عَمَلُ منْ طَبّ لمن حَبّ " إذا غضِب فسبّ،
أو رضي فمدح وأطنب. وما أحسن مادلَّ على هذا المذهب أشجعُ السُّلَمي بفحوى
كلامِه، فإنه قال:
أَعَلَيَّ لَوْمٌ أَن مَدَحْتُ مَعَاشِراً ... خَطَبوا إِليَّ المدْحَ
بالأَمْوالِ
يَتَزَحْزَحُون إذا رأَوْني مُقْبِلاً ... عن كلِّ مُتَّكأٍ من الإجْلالِ
وإذا لم يكن عليه لوم في مدح المُحسن إليه، فكذلك لا عتب عليه في ذمّ
المسيءِ إليه.
نعم، وأفاد أبو عثمان في رسالته فوائد لا يخفى مكانها على قارئها، وقام
فيها مقام الخطيب المِصقَع، والسَّهم النافذ، والنّاصر المدل، والمنتقم
المستأصل؛ فهل قال أحد ممن له يدٌ في الفضل، وقدَمٌ في الحكمة، وعرفان
بالأمور، وقوله معدود فيما يُقال، وحُكمه مقبول فيما يُثبَت ويُزال: بئس
ما صنع وساءَ ما أتى به؟ بل تهادَوْهُ وحفظوه، واستحسنوه وتأدّبوا به،
وحذوا على مثاله وإن كانوا وقعوا دونه.
ولم صنّف الناس المناقب والمثالب؟ ولِمَ نشروا أحاديث الكرام واللِّئام؟
وكثيرٌ من الناس - عافاك الله - لا غيبة لهم، أو في غيبتهم أجر، وقد وقع
في الخبر عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - : " اذْكُرُوا الفَاسِقَ بما
فيهِ كيْ تَحْذَرَهُ النَّاسُ " . وحدّثنا بُرهان الصوفي قال: ذمّ بِشر
الحافي بخيلاً ثم قال: إن البخيل لا غيبة له، قيل: وكيف؟ قال: لقول رسول
الله صلّى الله عليه وسلّم - : " يَا بَنِي سَلَمَةَ مَنْ سَيِّدُكُم؟
قالوا: الجَدُّ بنُ قيس على بُخْلٍ فيه، قال: فأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى من
البُخْل " . فذكره وليس هو بالحضرة.
وهذا عيسى بن فَرُّخَانْشاه عُزِل عن الوزارة وكان مُستخِفّاً بأبي
العَيْناء فوقف عليه أبو العَيْناء وقال: الحمد لله الذي أذلّ عزّتك،
وأذهب سطوتك، وأزال مقدرتك، وأعادك إلى استحقاقك ومنزلتك، فلئن أخطأت فيك
النّعمة، لقد أصابن منك النّقمة، ولئن أساءت الأيام بإقبالها عليك، لقد
أحسنت بإدبارها عنك؛ فلا أنفذ الله لك أمراً، ولا رفع لك قدراً، ولا أعلى
لك ذكراً.
فهل قال أحدٌ بئس ما صنع؟ وليس للراضي عن المُحسن أن يطالب المساء إليه
بأن يكون في مُسْكِهِ وعلى حال اعتدا له، لأنّ بينهما في الحال مسافةً لا
يقطعها الجواد المُبرّ ولا الريح العَصوف.
وذُكر محمد بن طاهر عند أبي العيناء فقال: ما دخلت عليه قطّ إلاّ ظننت أنه
من طلائع القيامة؛ قصير القامة، مشؤوم الهامة؛ خرجَ من خُراسان وهو
أميرُها، ويطمع فيها وهو طريدها، ويْلي على أُسِير الصَّغار طليق الهزيمة.
ووجدتُ رسالة لأبي العباس عُبيد الله بن دينار على ما قدّمت القول فيه؛
وأنا أرويها على وجهها لأنها مُفيدة، رواها لي المنصوريّ القاضي بأرَّجان.
أوّلها:
" إِن في الشكر، وإن قل، وفاءً بحق النعمة وإن جلّ، بل أقول: إن
الشاكر للنعمة، وإن أطنب وأسهب، لا يلحق شأوَ المبتدئ بها، ولا يخرج بأقصى
سعيه من أداء حقه فيها؛ لأن نعمته صارت سبباً لشكره، وداعيةً لذكره، فلها
فضل سبقها وموقعها وفضلها، فإن الشُّكر من أجلها، وإنها - حيث حلَّت -
عائدة بثناء جميل، وثواب جزيل؛ ولا خِلاف بين الحكماء أن الجالب خير من
المجلوب، والفاعل خير من المفعول.
ومَن لي بشكرك وأنت الذي لمّا قصدتك بالرغبة بلغت بي ما وراء المحبة،
وناديتك فأجبت من قريب، ولُذت بك فأنزلت البرّ والترحيب، فلمَمْتَ مني
شَعَثا، ورعيت لي سبباً لولا رعايتُك لكان رثّاً، ووفَّرت عليّ نعمة الجاه
واليد، وقمت لي مقام الركن والسند، فأصبحت لي على الدهر معيناً، ومن أحداث
الزمان ملاذاً حصيناً، وما زلت بكل خيرٍ قميناً، وجدَّدت لي أملاً قد كان
أخلق، وأمسكت مني بالرّمق، وتلقّيت دوني نبوة من عاتبك واستزادك، وجفوةَ
من تغبّطكَ فكادك؛ في حين عزَّ الشفيق، وخذل الشقيق، وجار الزمان، وتواكل
الإخوان؛ فكشف الله بك تلك الغُموم المُطبقة، وسكّن برأيك منّي نفساً
قلقة، فأنا، في قصوري عما أوجبه الله عليّ لك، كما قال الشاعر:
لَو أنَّ عُمري ألف حولٍ وقد ... بُدِّلت الساعة بالدَّهرِ
وَكان لي أَلف لسان لما ... نطقتُ من شكرك بالعُشْرِ
فشكر الله لك ما أتيت، وتولّى جزاءك على ما تحرّيت، وكافأك بأحسن ما نويت،
ولا أخلاك من أمل يُناط بك لتُحققه، وظنٍّ يُصرف إليك فتُصدِّقه، وشُكرٍ
يوفَرُ عليك فتستحقّه، وصان لك من النعمة راهنها، وبلّغك أقصى ما تؤمِّل
منها، وتفضّل عليك بما لا تحتسب فيها؛ وكلّ ما أغفلناه من الدُّعاء لك
مّما يرغب المرء في مثله، فوهب الله لي فيك، ووهبه لك في كل أسبابه.
فأما فضائلك والمواهب المقسومة لك فقد قادت إليك مودّات القلوب ووقفت عليك
خبيات الصدور، وارتهنت لك شكر الشاكر، وردّت إليك نفرة النافر، وحاطت لك
الغائب والحاضر، وأفحمت عنك لسان المُنافر، وقَصَرت دونك يد المتطاول،
وطامنت لك نخوة المُناضل، وأوفت بك على درجة الأدب والهمة والرياسة.
فبلّغك الله ذُرى المحبة والأمل، ووفقك لصالح القول والعمل، ولا زالت
رُبوع الحرية معمورة بطول عُمرك، والمكارم مؤيدة بدوام تأييدك، ولا برحت
أيامك محفوفة بالعزّ والسعادة، ونعمتك مقرونة بالنماء والزيادة، ووقاك
الله بعينه من الأعين، وحاطك بيده من أيدي المحن، وفَدَاكَ من النوائب
والأحداث.
والنَّكِب من قد فُقئت به عينُ النّعمة، واتّضعت بمكانه رتبةُ الهِمّة؛
فلا يصدر عنه آمل إلاّ بخيبة، ولا يضطرّ إليه حُرٌّ إلا بمحنة؛ إن أؤتُمِن
غّدر، وإن أجار أخفر، ولإن وَعد أخلف، وإن قَدَر اعتسف، وإن عاهد نكث، وإن
حلف حنث؛ تصدأ بمحاورته الأفهام، وتصطرخ منه الدَّولة والأقلام، سيان قام
أو قعد، وغاب أو شهد؛ إن كشفته كشفت عن عِلج فَدْم، يُقضى له بكل خِسّةٍ
وذمّ، ولم يقف للحرية على ربعٍ ولا رسم، ولا عرَف مكرمة في يقظة ولا حُلم؛
أسوأ الناس صنيعاً، وأشدّهم بالدّناءة ولوعاً، لم يسلك إلى المجد طريقاً،
ولا وجد يوماً من الجهل مُفيقاً، أولى الناس بشتمٍ وقذف، وأجدرهم بمجانةٍ
وسُخف، يَنطق قبحُ خَلقِه من سوءِ، خُلقه، ويدلّ بركاكة عقله على لؤم
أصله؛ إذا اكتنفتْه الحوادث لَوَى عنها شَدقه، وإن لزمه الحقّ لوَاه
ومحقه؛ وقد وفّر الله حظّه من الفدامة كما قصّر به في القامة، فهو بكل
لسانٍ مهجوّ، ولكلّ حرٍّ عدوّ، وإن عوتِب على الزَّهو والتيه، أقام فيهما
على تماديه؛ يَلُوث عمته على دماغ فارغ، وحمق ظاهر سائغ، فهو في أُخرِ
حالاته، عند نفسه كما قيل، صورةٌ ممثّلة أو بهيمة مهملة.
وصلتُ هذا الفصل بقولٍ فاضت به النّفس بعد امتلائها، وجاشت به بعد تردده
فيها، وما اضطرّني إليه إلا تتابع المكروه من جهته، والشرّ الذي لا يزال
يتعقَّبني به، وأنّه حين وج غِرة اهتبلها، ولما رأى الفرصة انتهزها، ولم
يرض حتى حسر عن الذراع يداً، فكشف القناع وجرّد العداوة والتعصّب، وأظهر
التسلُّط والتغلّب.
وأنا أعتذر إليك من أن أصل مخاطبتي لك بمثله، وإن كنتُ أجعله
بمنزلة اللّهو الذي أستعين به على الحق، والهزل الذي أستريح به من الجدّ؛
وقد قيل: من لم يذمم المسيء لم يحمد المُحسن، ومَن لم يَعرف للإساءة مضضا،
لم يجد عنده للإحسان موقعا.
وعلى أني لست أدري أمَيْلي إليك أصدق، أم انحرافي عنه أوثق، ورغبتي فيك
أشد، أم زُهدي فيه أوكد، ومودّتي لك أخلص، أم أنا على مصارمته أحرَص،
وسكوني إليك أتمّ أم نَبْوَتي عنه أحكم، وأنا على ذَمِّه أطبع، أم في حمدك
أبدع؟ كما لست أدري أحظُّك من الهمة والمروءة أجزلْ، أم حظُّه من
الدّناءةِ والقِلَّة أجل، ومكانك من الحزامة والكرم أرفع، أم محلُّه فيهما
أوضع؟ وكيف يُقرن بك أو يُساوي، وما أتأملك في حالٍ من الأحوال إلاّ وجدتك
فيها حُساماً قاضِباً، وشهاباً ثاقباً، وعُوداً صليباً، ورأياً عند مُعضِل
الخطوب مُصيباً؛ في شمائل حلوة عِذاب، وأخلاق معجونة بآداب؛ لا تتجافى عن
مَكرمة، ولا تُخِلّ لذي أمل بحُرمة، ولا تَؤودك الخطوب إذا اعتورتك، ولا
تتكاءّدُك الجهات إذا اكتنفتك، قد تعرَّقتك الأيام بحالتي النُّعمى
والبلوى، فكشف منك عن أمضى من الدَّهر عزْماً، وأرزن من رَضوى حلماً،
وأثبت من الليل جناناً، وأسمح من صوب الغَمام ندىً، وأمنعَ من السَّيف
جانباً، وأعزَّ من كُليبِ وائل صاحباً.
وما أتأمّله في حالٍ من الأحوال إلاّ وجدته برْقاً كاذباً، ورأياً عازباً؛
ركاكة ظاهرة، ونذالة وافرة، وهيئة خسيسة، ونفْساً على الذَّمّ حبيسة؛ لم
ينشأ منشأ أدب، ولا راضته أوّلية حسب، فهو دهره على وجل وذُعر؛ إن صال
فعلى القريب الدّاني، وإن همّ فبِمضِلاّت الأماني، فليس تتجاوز صولته
عبده، ولا يخاف عدوّه كيده، قد جمع إلى القُبح المخبر، بشاعة المنظر، وإلى
دمامة الخلق سوء الخُلُق؛ إذا فكّر المُفكِّر فيما أوتيَ من الحظّ، ومُنح
من الحال، أيقن بعُلوّ الجهل وفوز قِدحه، وإِكداء الباطل وكساد ربحه؛ هو
والله كما قال الشاعر:
عَدوٌّ لمولاهُ عَدوٌّ صديقِهِ ... وَتلك التي يأْتي اللئيمُ من الفِعْلِ
مُقَلَّمةٌ أظفارُه عن عَدوّه ... عَلَى أَقْرَبِيه ظاهرُ الفُحْش
وَالجَهلِ
وما أخطأ بوجهه قول الحَمدوني:
كأن دَمامِلاً جُمعت ... فصُوّر وَجهُه مِنها
والعجب كلّ العجب، والحديث الذي عندي سيان فيه الصّدق والكذب، ما يُظهره
من الانحراف والازْوِرار، على ما بي عنه من السَّلوة والاصطبار؛ وما محله
فيما يأتيه إلا محلُّ أمّ عمرو وما قيل فيها:
ألاَ ذهبَ الحِمارُ لأُم عَمْرو ... فلا رَجَعتْ وَلا رَجَع الحمارُ
بل هجوُه والله الفائدة التي يجب في مثلها الشُّكر، والأُحدوثة التي يحسن
فيها الذكر؛ فأما غضبه وتغيُّظه فغضبُ الخيل على اللُّجُمِ الدِّلاص؛ وأنا
أقول فيه كما قيل:
فإن كنتَ غَضباناً فلا زلتَ راغِماً ... وإِن كنتَ لم تَغضَب إلى اليومِ
فاغضَبِ
والله لو كانت له مثل أياديك التي لها مني موقع القطر في البلد القَفْر،
ولطف محلِّ الوصل بعقبِ التّصارم والهجْر، لما وجدني مُحتمِلاً له أذى،
ولا مُغضياً له على قذى؛ ولو كان تخويفه إيّايَ بمثل إعراضكَ الذي أدناه
يُقلق الوساد، ويُمرض الفؤاد، لما ألفاني له مُعتباً، ولا إليه مُغتذراً؛
فكيف وهو مَن لا يجب له حقّ الصَّنيعة، ولا ذمام أدب، ولا ذمار معرفة؛ لم
أُسرَّ برضاه لما رضي فأُساء بغضبه وقد غضب، ولا نفعني إقباله فيضرُّني
إعراضه، أنه بحمد الله كما قيل:
فتىً إن يرضَ لا ينفَعك يوماً ... وإنْ يَغضَب فإِنَّك لا تُبالِي
لستُ والله أحفلُ به أقبل أم أدبرَ، وسكَنَ أم نفر، ولا أُبالي بحالَتَي
سُخطه ورِضاه، ولا بأُولى أمره ولا بأُخراه. فأدام الله له سَوْرة
النَّبْوة والإعراض، وأعانه على الجَفْوة والانقباض، ولا أخلاه من الغضب
والامتعاض؛ فقد رضينا بذلك فيه حظّاً، واكتفينا به فيه وعْظاً.
وأخبرنا المرزُباني عن الصولي قال: كتب ابنُ مُكرَّم الكاتب إلى أبي
العَيناء:
" لستُ أعرفُ طريقاً للمعروف أحزن ولا أوعَر من طريقه إليك، ولا
مُستَزْرَعاً أقلَّ زكاءً ولا أبعدَ من ثَمرهِ خيرٌ من مكانه عندك؛ لأنّ
المعروف يُضاف منك إلى جنب دَنيّ، ولسان بذيّ، وجهل قد ملك عِنانك، وشغل
زمانك؛ فالمعروف عندك ضائع، والشكر لديك مهجور، وإنما غايتُك في المعروف
أن تحوزه، وفي مُوليه أن تكْفُرَه. " فكتب إليه أبو العيناء: بسم الله
الرحمن الرحيم
وَأَنتَ كما قال الإِلهُ فإِنَّما ... أَتيتَ بلفظٍ ضِعفُه فيك يُوجَدُ
أما بعد فقد وصل إليَّ كتابك؛ سبُّك وعرُّك، ولقد كان لك في سُدَيف
وَبُغَا ما يشغلك عن البذاء، ولكن الله (إذا أَرَادَ بِقَوْمٍ سُوءاً
فَلاَ مَرَدَّ لهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال).
وأنت امرؤٌ تزعُم أنك من أهل مَاذَرَايا، وهنالك حلّت بك الخزايا، من غير
نقصٍ لأهلها، ولا دفعٍ لفضلها، لأنّك تُحبُّها وتشْنَؤُك، وتنتمي إليها
وتدفعك؛ وإن امرءاً مُكرَّمٌ أبوه لجدير عند الفخر أن يُعفَّر فوه؛ وأمّا
أُمك فامرأة من المسلمات الغافلات، والغفلةُ مقرونة بالخير، والعجب لك
ولأخيك أنَّك لا تَنيك ولا يَنِيك، فعلامَ غررتم الحرائر واستهْديتم
المهائر، وأنتم قومٌ تلَفَّقُون ما يأفِكون، واله أعلم بما تُوعُون؛ وفيمَ
خطبتم النساء وأنتم تُخطبون، وكيف نقدتم المُهور مع حاجتكم إليّ الذكور،
ثم أظهرتم حُبّ النِّسا، وبكم عِرق النّسا، وكيف ادّعيتم يوم الحرب
الطِّعان، وأنتم معشرٌ تَخِرُّون للأذقان، ولكم في كل يوم وِقاع تُلْفون
وُقعاً للصدور، والرِّماح في أعجازكم تمور، وقد طبتم أنفسا بأن أصبحت
نساؤكم عند جيرانكم، ورِجالكم عند غلمانكم، فإذا سببتموهُنَّ بالزِّنا
سببنكم بالبغاء، وقد - لَعَمري - أظهرتم الدَّف، ونقرتم الدُّف، وأكثرتم
الطَّعن وادّعيتم الإثآر؛ فلما احتيج منكم إلى اللقاء، وتُنجز منكم
الوَفاء، انهزم الجمع وولَّيُتم الدُّبُر، فقُبحاً لكم آل مكرم قُبحاً
يقيم ويلزم.
فلسْتُم عَلَى الأَعقابِ تَدمَى كلومُكم ... ولكن على أَعْجَازِكُم
يَقْطرُ الدَّمُ
فيا بُؤسى للعروس وإزارها الذي لم يُحلل، وفرعها الذي لم يُبلل، وللظّبية
الغريرة وطرفها الفتّان، وقولها للأتراب، أما لآل مُكرَّك زباب؟ وقد زعمت
النساء، غير ما إِفكٍ: أنّك وأباكَ وأخاكَ جندٌ ما هنالك مهزومٌ من
الأَنباطَ.
وذكرت أنك لا تعرف للمعروف طريقاً أحزن ولا أوعر من طريقه إليَّ، ولا
مُسْتزرعاً أقل زكاءً ولا أبعد من ثمره خيرٌ من مكانه عندي.
فلو كان ما وصفت على ما ذكرت لما لحقك كُفر إنعام، ولا شكر إحسان، لقصور
جدَتِك عن التفضّل وهمِّك عن الأفضال. بَلَى، أستغفر الله! لو وجدت فضلاً
لوجهت به إلى العاملين عليها أعني أُمَّ الفُلْك، القاضية عليك بالهُلك؛
وأين أنت فيلحقني إكرامك، أو ينالني إنعامك؟ هيهات! جلَّ الأمر عن الحرش،
وعفَّى السيلُ العَطَن؛ ولكنك يا أبا جعفر - وأنى لك بِجعفَر - لا تعرف
للجِماع طريقاً أسهل مأتىً ولا أقرب مأْخذاً من طريقه إليك، وحلوله عليك؛
هذا مع دَنَس أثوابك، ووَضَر أطرافك، ونتن أرْواحك.
وزعمت أن المعروف يحصل مني في حسب دني ولسان بذيّ، فانظر لك الوَيلات كيف
ارتقيت، وإلى من تعدَّيت؟ وهل فوق رسول الله صلى الله عليه مَفخَر، وهل عن
خُلفاء الله مَرْغَب؟ ولولا عدل سلطاننا وفضل أحلامنا، وأن الاقتدار يمنع
الحرّ من الانتصار، مع دقّتك عن المجازاة، وسقوطك عن المُلاحاة، لاصطملكَ
مِنّي الاعتزام؛ فاشكر لُؤْمَك إِذ نَجَّاك، وَخَصْمَك إذ رفعَ قدَره عنك.
وأما البذاء فما أعتذر إليك من إقماع اللّئيم وتعظيم الكريم، ولذلك أقول:
إذا أَنا بالمعروفِ لم أُثْنِ صادقا ... ولم أَشتُم الجِبْسَ اللَّئيمَ
المذَمَّما
ففيمَ عرفتُ الخيرَ والشرَّ باسمهِ ... وَشَقَّ ليَ الله المَسامِعَ
وَالفَمَا
وأما الجاحظ فإنه يقول في رسالة: سألتني - أبقاك الله - عن فلان، وأنا
أخبرك بالأثر الذي يدلّ على صحّة الخبر، وبالواضح الذي يدلّ على الخَفيّ،
والظاهر الذي يقضي على الباطن؛ فتَفهَّم ذلك - رحمك الله - ولا قوة إلاّ
بالله.
فمن ذلك أني رأيته، وهو في جيرانه كالحيضة المنسية، وكلّهم يعرفه
بالأُبنة، وله غُلام مَديد القامة، عظيم الهامة، ذو ألواحٍ وأفخاذٍ وأوراك
وأصداغ؛ أشعر القفا، يلبس الرقيق من الثياب، ويُثابر على العطر ودخول
الحمّام، ويتزيّن ويقلّم الأظفار؛ وكان - مع هذه الصِّفة - المدبِّر
لأمره، والمشفَّع لديه، والحاكم على مولاه دون بنيهِ وأهله وخاصّته،
والصارف له عن رأيه، إلى رأيه، وعن إرادته إلى هواه، وكان أكثر أهله معه
جلوساً، وأطولهم به خَلْوةً، ولا يبيتُ إلاّ معه، وإذا غضب حَزَنه غضبه
وطلب رِضاه، وكان أيام ولايته لا يتقدّمه قريب ولا بعيد، ولا شريف ولا
وضيع؛ إن ركِب فهو في موضع صاحب الحرس من الخليفة، وإن قعد ففي موضع الولد
السارّ والزوجة البارّة، وإن التوت على أحد حاجة كان له من ورائها، وكانت
أهون عليه من خلع نعليه، وكان يبيت في لحافه.
فحكمنا عليه بهذا الحكم الظاهر، ولا حُكم القًضاة بالتسجيل، وتخليدها في
الدواوين، ولا كالإقرار بالحقوق وشهادات العدول.
وكتب العُتبي إلى صديق له يحذّره رجلاً، ويصف أخلاقه فقال: احذر فلاناً،
فإن ظاهره برٌّ وغيبه عداوة، وإن أفشيت إليه حديثك وضعه عند عدوّك، وإن
كتمته إياه شتمك عند صديقه، لا يصلح لك عند نفسه حتى يُفسدك عند غيره؛ وهو
صديقك بما يلزمك من حقه، وعدوّك بما يُضيع من حقه عليك؛ إن دنوت منه آذاك،
وإن غبت عنه اغتابك، يلطّخ... صاحبه بأذاه، فإن غسله بالإعتاب أعاده
بالعتب، وإن تركه عُيِّر به؛ السلامة منه أنلا تعرفه، فإن عرفت فهو الداء،
إن تداويت لم ينفعك، وإن تركته قتلك، أخلط الناس جدّه بهزله ليمنعك ما في
يده منع هزْل، ويغلبك على ما في يدك مسألة جِدّ.
ووجدتُ أيضاً رسالة لأبي هفّان إلى ابن مُكَرَّم وهي: أما بعد يا بن مكرم
ضدّ اسمه، وخطيئة أبيه وأُمّه، يا سُبّة العار على سُبته، ولعنة إبليس على
لعنته، ما أظنّك من نُطفة، ولا كانت لواضعتك عُذرة؛ أفرغك أبوك من
سَلْحَةٍ على سلحة، وأجراك من أمّك في فقحةٍ إلى فقحة، فأنت كما قال
الشاعر:
لَعْنَةُ اللهِ عَلى نَتْنَيْهما ... شِعْرَتَيْنِ احْتَكَّتَا في طَلَبِهْ
أولُك زِينةٌ وآخرك أُبنَة، فكُلُّك لعنة في لعنة، تقصع القمل بأسنانك،
وتمسح مُخاطك بلِسانك، وتستنزل مَنيَّك ببَنانك، ومَنيَّ غيرك بعجانك،
عبدُك يصفعك، وخادمك يقمعك، وكلبك يلطعك، وصديقك يقطعك، نَفَسُك فُساء،
وخَشمك خَراء، وريقك ماءُ العَذِرة، وكل خِلالك قذرة؛ وأنت للأحرار عيّاب،
وبين الكرام نمّام، وأنت للأُدباء حاسد، وللعلماء شاتم، وبالجليس هامز،
وفي المُحسن إليك غامز، تُظهر جورَك، وتتعدّى طورك، مَهين في نفسك، عُرَّة
في جنسك، حالف في كل حق وباطل، كذوب على الجادّ والهازل، تطلب أن تُهجى،
وتستدعي أن تُزَنَّى، وقد سبق القول في مثلك، مع نذالة فعلك، ولؤم أصلك.
أَما الهِجاءُ فَدَقَّ عِرضُك دونَه ... والمَدْحُ عَنك كما علِمت جَليلُ
فاذهَب فأَنت طليق عِرضِك إنَّه ... عِرضٌ عززتَ به وأَنت ذَليلُ
فأنت - يا بن الكَشْخان القرنان الدَّيُّوث الصَّفْعَان - عتقٌ
لأُستِ الشيطان - لا لوجه الرحمن، فالهجاء من أن يُعذَّب بك في أمان، فأنت
بعزّ لؤمك في سُلطان، معرفتك تُشين، وقطيعتك تزين، وذكرك سُبة، وقتلك
قُربة، لا يُحصي الخلق عيوبك، ولا تُثبت الحفظة ذنوبك، أنت بالله مُشرك،
وفي خلقه مُتهتّك، نقصُك مفروض، ودينك مرفوض، وبكلّ قبيحٍ منعوت، وعند
العالم ممقوت، أحسن آدابك الزَّندقة، وأفضل حالاتك الصدقة، نذْل الأُبوّة،
رذْل الأُخوّة، عدوّ المُروّة، لم تؤمن بنبوّة، ولم تُعرف بفُتوة، تقصد
الكريم بسبابك، فيُذلّك بترك جوابك، جئت بأُمٍّ من حمام الدجّال، تُوازي
بها أمهات الرجال، لا صوم ولا صلاة، ولا صدقة ولا زكاة، لا تغتسل من
جنابة، ولا تهتمُّ بإِنابة، عقوقك بأبيك أنه غبر من يدّعيك، لقاتلك أرفع
الدَّرج، وما على قاذفك من حرج، وكلّ ذلك بالآيات والحُجج، الحدُّ لتارك
وصفك، والنار للمُطْنِب في مدَْحِك، ولقارئ مثالبك وكاتب معايبك ثواب أكثر
مما لك من العقاب، لك خُلِقَت سَقَر، ومن أجلك يعذَّب البشر، أحسن في
عينيك من القمر، ما تستدخله من الكَمَر، تهيب المؤمنات والمؤمنين، وتقذف
المحصنات والمحصنين، إذا ليسوا لك بآباء، ولست لهم في عِداد أبناء، فأنت
كما قال الشاعر:
مُغْرىً بِقَذْفِ المُحَصَنا ... تِ وَلَسْتَ من أبنائِها
آنف للعلم الذي حويته، وأغارُ على الشعر الذي رويته، فأنت - وإن غلطت
بكلمة طريفة، أو حجّة حكيمة، أو نادرة مليحة، اعتباراً للسامع وفكرة
للعاجب - سفيه على إفراط قَذَرك، حسود على شدة بَخَرك، ووقّاع على قاتل
ذَفَرك، تُمازح فلا تُحسن وتُجاب وتُذعن، إن تُرِكت عبثت، وإن عُبثَ بك
استغثت، فَمَثَلك " كمثل الكلب، إنْ تَحْمِلْ عليه يَلْهَثْ أوْ
تِتْرُكْهُ يَلْهَثْ " ، فاستمع يُشبهك في الأيام، يا عيب المعايب، ويا
شين المحاضر والمغايب، فلك المثل الأسفل، والقياس الأرذل، والشبه الأنذل
كما قيل:
وَأَدعوكَ للأَمر الذي أَنتَ شينُه ... على شينهِ يا فاضحاً للفَضائح
ووجدت أيضاً رسالة أفادِنيها أبو محمد العَروضيّ لابن حمّاد في أبي مُقلة
أبي عليّ يُمزّقه فيها، ويذكر خساسة أصله، وسقوط قّدّره، ولؤم نفسه، وفُحش
منشئه، تركتُ تخليدها في هذا المكان، وكذلك تركتُ غيرها هرباً من التطويل.
وبعد فحمدُ المُحسن وذمّ المُسيء أمران جاريان على مرّ الزمان مُذْ خلق
الله الخلق، وعلى ذلك يجري إلى أن يأذن الله بفنائه، وهو عزّ وجلّ أول من
حَمِد وذمَّ، وشَكَر ولامَ، ألا تراه كيف وصف بعض عباده عند رضاه عنه
فقال: (نِعْمَ العَبْدُ إنَّهُ أَوَّابٌ)، وقال في آخَر(إِنَّهُ كانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ)، وعلى هذا، فإنه أكثر من أن يُبلغ آخره، ثم انظر كيف
وصَفَ آخر عند سخطه عليه وكراهته لما كان منه فقال: (هَمَّازٍ مَشَّاءٍ
بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ
زَنِيمٍ).
وهذا فوق ما يقول مخلوق في مخلوق.
وقال الحسن البصري: الهمّاز: العيّاب، ومشّاء بنميم: ينقل الكلام القبيح،
منّاعٍ للخير: بخيل، معتدٍ أثيم: ظلوم ذميم، عُتُلّ: جاف، والزنيم:
الدَّعِيُّ.
قال أبو سعيد السّيرافي: العُتُلّ: نُراه من قولهم جيءَ بفُلان يُعْتَل
إذا غُلِظ عليه، وعُنّف به في القود.
وكيف يأثم الإنسان في غيبة من كان قلبُه نغِلاً بالنِّفاق، وصدره مريضاً
بالكُفر، ونفسُه فائضة بالقساوة، ووجهه مكسوراً بالصَّفاقة، ولسانه
ذَرِباً بالفُحش والبذاءة، وسيرته جارية على الكيد والعداوة، وعِشرته
ممقوتة بالنكد والرداءة؛ وقد أثنى الله على واحدٍ ولعن آخر، وحَطّ هذا إلى
الحُشّ ورفع ذلك إلى العرش، وعاتب، وأنّبَ ولام وذَمَّ؛ وكذلك رسوله صلى
الله عليه وسلم، ومن تقدّمه من الأنبياء والمرسلين والأولياء المخلصين؛
وعلى هذا فُورِق السّلف الطاهر، والصحابة العِلية، وهم القُدوة والعُمدة،
وإليهم يُنتهى في كل حال، وعليهم يُعتمد في كلّ أمرٍ ذي بال.
فمن ذا يُزري على هذا المذهب إذا خرج القول فيه مَعْضوداً بالحُجّة،
ممدوداً بالمعذرة، معقوداً بالنصفة، وكان فيه برد الغليل، وشفاء الصدر،
وتخفيف الكاهل من ثقل الغَيْظ على أجمل وجهٍ وأسهل طرق، مع مُسامحةٍ
ظاهرة، وتغافُل عريض؟
وقيل لبعض الصّالحين: أيُّ شيءٍ ألذّ؟ قال: ركوب هوىً وافق
حقّتا، وإدراك شهوةٍ لا تثلِم دينا، وقضاءُ وطَر لا يَتَحيَّف مُرُوَّة،
وبلوغ مُرادٍ لا يُسيَّر قالةً قبيحة؛ والمذهب الأول مذهب الزُّهاد
والمتأبّدين، وأصحاب الوَرع والمتعبّدين.
ونحن قد بيّنا الأصل في هذا الباب، فليس بنا حاجة إلى التكثير؛ وكيف
يلزمنا حكم من يتعجرف في قوله ويختار على رأيه، ويعترض بجوره.
ونحن قد اقتدينا بالله رب العالمين، وجرينا على عادة الأنبياء والمرسلين
وأخذنا بهَدْي عباد الله الصالحين؛ وإنما أشكل القول في هذا المذهب على
قوم مدحوا الصّمت، وكرِهوا كثير القول؛ وقليل الكلام عندهم فضل، وكثيره
هُجْرٌ، وفيه اللّغو الذي يجب أن يُتجنّب، والحشو الذي لا ينبغي أن يُعتاد.
وهؤلاء قوم - أكرمك الله - لا يعرفون فضل ما بين التفيهُق المذموم
والبلاغة المحمودة، والتشدُّق المكروه والخطابة الحسنة، وما هو من باب
البيان المشتمل على الحِكمة، وما هو من باب العِيِّ الشَّاهد بالهُجنة؛
ومتى كان ذكر المهتوك حراماً، والتشنيع على الفاسق مُنكراً، والدلالة على
النّفاق خطَلاً، وتحذير الناس من الفاحش المتفحّش جهلاً؟ هذا ما لا يقوله
من قام بالموازنة وبالمكايلة، وعرف الفرق بين المكاشفة والمجاملة؛ وإنما
غَزُر الأدب، وكثُر العلم، وجزُلت العبارة، وانبعَجَت العِبر، واستفاضت
التجارب، لما وقفوا عليه من أنباء الناس وقصصهم وأحاديثهم في خيرهم وشرهم،
وفي وفائهم وغدرهم، ونُصحهم ومكرهم، وأمورهم المختلفة عليهم، والحسن الذي
شاع عنهم، والقبيح الذي لصق بهم، والمكارم التي بقيت لهم، والفضائح التي
رَكدت عليهم؛ والدنيا دار عمل؛ فمن عمل خيراً ذُكر به، وأُكرم من أجله،
ولُحظ بطرْف الوقار، وصين عِرضه عن لصوص العار والشنار، وأُلحق بأصحاب
التوفيق، ومن له عند الله الوزن الراجح، والوجه المُسفر؛ ومن عمل شراً
لِيم عليه، وأُهيم من أجله، ونُظر إليه بعين المَقْت، وأَلصق بعرضه كل
خِزيّ، وبيع فيمن ينقُص لا فيمن يزيد؛ والجزاء وإن كان مؤخراً إلى دار
الآخرة لأهله، فإن بعض ذلك قد يُعجَّل لمُستحقه، ولهذا قال الله عزّ وجلّ
في تنزيله: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، ولَهُمْ فِي الآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ).
والذي ذكرته عن الجاحظ فليس هو أول من اقتضبه وسنّه، بل قد سلف فيه قوم
كرام، وخلف عليه ناس من جلة الناس. أنا قرأت رسالة لابن المقفع في معايب
بعض آل سُليمان ابن عليّ الهاشميّ، وكذلك أصبتُ رسالة لسهل بن هارون في
مثالب الحرَّاني، ورأيت أيضاً رسالة لسعيد بن حُميد في فضائح آل عليّ بن
هشام؛ وحتى الصُّولي بالأمس ذمَّ بعض بني المُنَجّم في رسالة له.
وحدثنا حمزة المصنّف عن أبي البغدادي قال: كتب أبو العَيناء إلى أحمد بن
أبي دؤاد: أما بعد فالحمد لله الذي حبسك في جلدك، وأبقى لك الجارحة التي
بها تنظر إلى زوال نعمتك، قال: وهي طويلة، قال: وقال أبو العَيْناء: لولا
أن القدر يُعشي البصر، لما نهى ولا أمر، ومن غريب هذا الفنَ رسالة لأبي
العباس محمد بن يزيد في خبائث الحسن بن رجاء، ورأيت أيضاً رسالة للعمري في
رقاعات الفضل بن سهل ذي الرياستين.
فأما الشعراء وأصحاب النظم، وأرباب المدح والهجاء، والثَّلب والحمد،
والتشنيع والتَّحسين فهم كالطِّم والرِّم؛ لا يكسبون إلا بهذا المذهب، ولا
يعيشون إلاّ على هذا الاختيار، ولهم الهِجاء المُنكر، والقول المُخزي،
والقذْع المؤلم، واللفظ الموجِع؛ والتعريض الذي يتجاوز التصريح، والتصريح
الذي يجمع كل قبيح، وأمرهم أظهر من أن يُدلّ عليه، وشأنهم أبينُ من أن
يُردّد القول فيه.
وإنما المَدار الصّدق في القول، وعلى تقديم الحق في العقد، وقصد الصّواب
عند اشتباه الرأي وغَلَبة الهَوى.
فأما قول أبي الحرث حمين وقد سُئل عمّن يحضُر مائدة محمّد ابن
يحيى، وجوابه: الملائكة، قيل: إنما نسألك عمن يأكل معه، قال: الذُّباب فإن
هذا من باب التملُّح والمجانة، وليس من قبيل الصدق في شيء؛ وإن كان بعض
الصدق مشوباً، وبعض الحقّ ممزوجاً فلا بأس ولا حرج، فإن ذلك القدر لا يقلب
الصدق كذباً، ولا يُحيل الحق باطلاً وأين المحضُ من كل شرٍّ، والخالص من
كل خير؟ إنك إن رُمت ذاك في عالم الكون والفساد، ودار الامتحان والتكليف،
مع هذه الطبائع المختلفة، والعناصر المتمازجة، والأسباب القريبة، رُمت
محالاً، ورائم المحال خابط، وطالب الممتنع خائب، ومُحاول ما لا يكون
مَكْدود مُعَنّى، ومحدود مُعدّى، ومرجعه إلى النّدم، وغايته الأسف الذي
يشجو النّفس، ويَمْرُس الفؤاد، ويُوجع القلب ويُضاعف الأسى، وربما أفضى
إلى العطب.
قد ذكرنا - حاطك الله - جملة من القول رأينا تقديمها والاستظهار بها، قبل
أخذنا فيما أنشأنا له هذا الكلام، قصداً لفلّ حدّ الطاعن، وحسماً لمادة
الحاسد، وتعليماً للجاهل، وإرشاداً للمتحيِّر، واحتجاجاً على من يُدِلّ
بحفظ اللسان، وكتمان السرّ، وطيّ القبيح، ومُسالمة الناس، واغتفار المنكر؛
وهو مع ذلك في قوله كالأسد في غيله، والنِّمر في أشِبِه، والثُّعبان في
وِجاره، حتى إذا غُمِز غَمْزةً، أو وُخِز وَخْزَةً، رأيت معاقد حلمه
مُتحللة، ودخائر صبره منتهية، وكظمه الذي كان يُدلُ به مفقوداً، وجلده
الذي كان يدعيه باطلاً؛ وما أكثر من يتكلّم - على السلامة من النفس
والمال، وطيب القلب، ورخاء البال، وعند مواتاة الأمور، وطاعة الرجال،
ومُساعدة المراد - بالحكمة البالغة، والموعظة الحسنة، وبالنظر الدقيق،
واللفظ الرقيق، حتى إذا التوت عليه حالٌ، وتعسّر دون مُراده أمر، وعرض في
بعض مطالبه تعقُّد، سمعتَ له هناك زَخرةً ونخرةً، وضجرة، وكَفْرة، كأن لم
يسمع بالحلم والتحلُّم، والصبر والتصبُّر؛ يخرج من فروته عارياً من الحلم
والكظم، بادي السَّوأَة بالبذاء والجهل، كما يخرج الشَّعر من العجين،
ولعلَّ ما نزل به وحلَّ عليه لم يرْزأَه زِبالاً ولا مسح عنه عِذاراً.
وهذا هو اللئيم الذي بلغك، والسّاقط الذي سمعت به والله تعالى يقول: (لاَ
يُحِبُّ اللهَ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إلاَّ مَنْ ظُلِمْ)؛
وروى أصحابنا عن ابن عباس أنه قال: إلا مَن لَم يُكْرَم، في ضِيافتِه، فإن
كان هذا التأويل صحيحاً، وهذا الوجه معروفاً، فأنا ذلك المظلوم، ولا بد
لمن ظُلم من أن يتظلّم، وكيف يكون المظلوم إذا انتصر ظالماً، والله يقول:
(وَلِمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوُلئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ
سَبِيلٍ)، ولو كان المظلوم إذا تظلّم ظالماً، لكان الظالم إذا ظلم
معذوراً؛ وكما هجّن الله لوم المُحسن، فكذلك حسَّن توبيخ المُسيء، وكما
أثاب على تزكية من كان طاهراً، كذلك آجرَ على جرْح من كان مَدخولاً؛ ألا
ترى أن التقرّب إلى الله بِعداوة أبي جهل، وذمِّه ولعْنه وذِكر لؤمِه
وخَسَاسته، كالتقرب إلى الله بولاية أبي بكر ومَدحِهِ والترحُّم عليه وذكر
فضْله وبلائه ونُصرته؛ وهذا مُستمر في غير أبي جهل ممَّن عادى الله ورسوله
صلى الله عليه، كما أنه مُستمر في غير أبي بكر ممن أطاع الله ورسوله؛
وإنما الأمور بعواقبها، والمذاهب بشواهدها، والنتائج بمقدماتها، كما أن
الفروع بأُصولها، والأواخر بأوائلها، والسُّقوف بأساسها.
ولستُ أدّعي على ابن عبَّاد ما لا شاهد لي فيه، ولا ناصر لي عليه، ولا
أذكر ابن العميد بما لا بيّنة لي معه، ولا برهان لدعوايَ عنده، وكما
أتوخّى الحقّ عن غيرهما إن اعتراض حديثه في فضل أو نقص، كذلك أعاملها به
فيما عُرفا بين أهل العصْر باستعماله، وشُهِرا فيهم بالتحلّي به، لأنَّ
غايتي أن أقول ما أحطتُ به خُبرا، وخفظته سماعاً.
وسهلٌ عليَّ أن أقول، لم يكن في الأولين والآخرين مثلهما، ولا
يكون إلى يوم القيامة من يَعْشِرهما اصطناعاً للنّاس، وحِلْماً عن
الجُهّال، وقياماً بالثواب والعقاب، وبذلاً لقنْية المال، ولكلّ ذُخرٍ من
الجواهر والعقد؛ وأنهما بلغا في المجد والذِّروة الشمّاء، وأحرزا في كل
فضلٍ وعلم قَصَب السَّبق، وأن أهل الأرض دانُوا لهما، وأن النقص لم يشنهما
بوجه من الوجوه، وأن العجز لم يَعْترهما في حال من الأحوال؛ وأنهما كانا
في شعار إمام الرافضة وعصمته المعروفة، وأن الاستثناء لم يقع في وصفهما في
حالٍ، لا في الصناعة والمعرفة، ولا في الأخلاق والمُعاملة، ولا في الرياسة
والسياسة، ولا في الأُبوّة، والعُمُومة، ولا في الأُمومة والخؤولة، وأن
الولادة قرَّت على شرف المَحْتِد، والمنشأ جَرَى على كَرَم المَولِد؛
فالجوهر فائق في الأصل، والمجدُ عميم في الفرع، والنِّصاب مقوَّم بالقديم
المذكور، والخير شامل في الحديث المشهور، والنجابة معروفة عند الوليّ
والعدوّ، والعِرقُ نابض بكل فعل رضيّ، والغَور بعيد على المتأمل، والأمر
كلّه عالٍ عن المتطاول، وأنه كما يُقال لهذا؛ ابن العميد لنبَاهة أبيه،
كذلك كان يُقال لذاك ابنُ الأمين لخير كثير كان فيه، أن العميد وإن كان
مقدّماً في الكتابة، فقد كان الأمين معظَّماً في الديانة، والكِتابة صناعة
تدركها الخُلوقة، والديانة حلية لا تزْداد إلا الجِدَة، وتلك الدنيا هي
زائلة، وهذه الآخرة وهي باقية، والله تعالى يقول: (وَالآخِرَةُ خَيْرٌ
وَأَبْقَى)، (وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ)؛ على أن الأمين كتَبَ لرُكن
الدولة كما كتب العميد لصاحب خراسان. والأمين كان ينصر مذهب الأُشْنانيّ
تديُّناً وطلباً للزُّلْفى عند ربّه، والعميد كان يعمل لعاجلته؛ وإن قلتَ
كان الأمين معلّماً بقرية من قُرى طالقان الدَّيلم، قيل: وكان والد
العَميد نخّالاً في سوق الحنطة بقُمّ.
فدع هذا ونظيره، وأنك متى أردت أن تُحصي صنائع ابن العميد وابن عبّاد أردت
عسيراً، ومتى أثرت أن تُحَصِّل فضائلهما حاولت ممتنعاً، وأنهما كانا
بالسياسة عالمَيْن، ولأولياء نِعَمِهما ناصحين، وإلى الصَّغير والكبير
متَحَبّبيْن، وعلى القاصي والداني حَدِبَيْن، ولأموالهما باذلين،
ولأعراضهما صائنين، وفي مرضاة الله دائبين، وعلى هدي أهل التُّقى جاريين،
ومن كل دنسٍ ونطف بعيدين نزهين؛ وأنهما لو بقيا لنزَل عليهما الوحي،
ولتجدّد بهما الشَّرع، وسقط بمكانهما الاختلاف، وزال بنظرهما ما فيه
الأُمة من هذا العيش النَّكد، والشؤم الشّامل، والبلاء المحيط، والغلاء
المتَّصل، والدِّرهم العزيز، والمكْسب الدَّنِس، والخوف الغالب، ولكانت
الأرض تُخرج أثقالها، وتلفِظُ كنوزها، ويستغني من ألم الفقر أهلها، ومن
فضيحة الحاجة أربابها، ويعود ذوي الدين ناضراً، وخامل المروَّة نَبِيهاً.
ولكن قد يسمع هذا الكلام مني من شاهدهما، وتبطّن أمرهما، وخبر حالهما وعرف
ما لهما وما عليهما، فلا يتماسك عن زجري وخسائي وإسكاتي ومَقْتي، ولا
يُنَهْنهه شيء عن مُقابلتي بالتكذيب واللّوم، ولا يجد بداً من أن يردّ
قولي في وجهي، ولا يسعه إلا ذاك بعد ازدرائي وتجهيلي، ولا يلبث أن يقول:
انظُروا إلى هذا الكذب الذي ألّفه، وإلى هذا الزُّور الذي فوّقه، والباطل
الذي وصفه، والحقّ الذي دفعه بسبب ثوب لعله أخذه، أو درهم ثنى عليه كفّه،
أو حاجةٍ خسيسة قُضيت له؛ تبلغ قلّة الدين وسُوء النظر فيما يُتعقّب
بالتقبيح والتحسين أنه يمدح واحداً مَقْروفاً بالزَّندقة والكُفر، ويُقرّظ
آخر معروفاً بالإلحاد والسُّخف، ويصف بالجود من كان أبخل من كلب على عقي
صبيّ ويدّعي العقل لمن كان أحمق من دُغَة؛ ومن أظلم ممن يصفالسفيه
بالحصانة، واللئيم بالكرم، والمتعجرف بالأناة، والعاجز بالكفاية، والنّاقص
بالزيادة، والمتأخر بالسّبق، والعنيف بالرِّفق، والبخيل بالسخاء، والوضيع
بالعلاء، والوقاح بالحياء، والجبان بالغناء؟ فلا يكون حينئذٍ لقولي قابل،
ولا لحُكمي ملتزم، ولا لنَصَبِي مرجوع، ولا لسعي نُجح، ولا لصوابي مُختار،
ولا لحُدائي مستمع؛ وفي الجملة لا يكون لدعْواي مُصَدّق.
ولَعمري لو انقلبت عن ابن عبّاد - بعد قصدي له من مدينة السّلام
وإناختي بفنائه مع شدّة العُدم والإنقاض، والحاجة المُزعجة عن الوطن،
وصفْر الكفّ عما يُصان به الوجه؛ وبعد تردُّدي إلى بابه في غِمار الغادين
والرائحين، والطامعين الرّاجين، وصبري على ما كلّفني نسخه حتى نشِبتُ به
تسعة أشهرٍ خدمةً وتقرُّبا، وطلباً للجدوى منه، والجاه عنده، مع الضَّرع
والتملُّق - ببعض ما فارقت من أجله الأعزَّة، وهجرت بسببه الإخوان، وطويت
له المهامِه والبلاد، وعلى جزءِ مما كان الطّمع يُدندن حوله، والنفس تحلم
به، والأمل يطمئن إليه، والناس يعذرونه ويحققونه، لكنت لإحسانه من
الشاكرين ولإساءته من السَّاترين، وعند ذكره بالخير من المساعدين
المصدقين، وعند قرفهِ بالسُّوء من الذّابّين الممتعضين. والشاعر يقول:
من يُعطِ أثمانَ المحامد يُحمَد
والآخر يقول:
والحمدُ لا يُشتَرى إِلاّ بأَثمان
والآخر يقول:
وإن المجدَ أَولُّه وُعور ... ومَصْدَرُ غِبّة كرمٌ وخِيرٌ
وإنك لن تنالَ المجدَ حتّى ... تجودَ بما يَضَنُّ به الضميرُ
بنفسِك أَو بملكك في أُمورٍ ... يَهاب ركوبَها الورَعُ الدَّثور
والآخر يقول:
والْحمدُ لا يُشتَرى إلا له ثَمن ... مما يَضَنُّ به الأَقوامُ معلومُ
والجودُ نافيةٌ للمال مُهلِكة ... والبُخْلُ مبق لأَهلِيه ومَذمُومُ
وقال الآخر:
ومن لا يَصُن قبلَ النّوافِذ عرضَه ... فيُحرزَه يُعْرَرْ به ويُحَرَّقِ
ومن يلتمِسْ حسْنَ الثناءِ بمالِهِ ... يَصُنْ عِرضَه من كل شنعاء مُوبِق
ولكنني ابتُليتُ به، وكذلك هو ابتُليَ بي، ورماني عن قوسه مُغرقا فأفرغتُ
ما كان عندي على رأسه مغيظاً؛ وحرَمَني فازدَرَيته، وخصّني بالخيبةِ التي
نالت مني، فخصصته بالغيبة التي أحرقته، والبادي أظلم، والمنتصف أعذر؛ وكنت
كما قال الأول:
وإِن لسَاني شَهدةٌ يشتَفَى به ... أَجَلْ وعَلَى مَن صَبَّه اللهُ علقَمُ
ولئن كان منعني ماله الذي لم يبق له، فما حظر عليَّ عرضه الذي بقي بعده،
ولئن كنتُ انصرفت عنه بخُفَّي حُنين لقد لصق به من لساني وقلمي كل عارٍ
وشَنَار وشَيْن، ولئن لم يرني أهلاً لنائله وبرّه، إني لأراه أهلاً لقول
الحق فيه، ونثِّ ما كان يشتمل عليه من مخازيه، ولئن كان ظنَّ أن ما يصير
إليّ من ماله ضائع، إني لأتيقّن الآن أن ما يتّصل بعرضه من قولي شاعر،
والحساب يُخرج الحاصل من الباقي، والنَّظرُ يميّز الصحيح من السّقيم،
والاعتبار يفرد الحق من الباطل، والمُنصف في الحُكم يعذِر المظلوم ويلوم
الظالم، والشاعر يقول:
فإِن تَمنَعُوا ما بأيدِيكُمُ ... فلن تمنَعُونا إذَن أَن نَقولاَ
وقال آخر:
فيا قَوْمَنا لا تظْلِمُونا فإِنَّنا ... نَرَى الظُّلْم أَحياناً يُشِلُّ
ويُعْرِجُ
ويَترُك أَعرَاضَ الرِّجال كأَنَّها ... فريسَة لحْمٍ ليسَ عَنها
مُهَجْهِجُ
وقال آخر:
إنّ الذي يَقْبِض الدُّنيا ويَبْسُطُها ... إن كانَ أَغناك عَنّي فهْو
يُغْنيني
ماذا عليَّ وإِن كنتُم ذوِي رَحِمي ... أَن لا أُحِبَّكُم إِذْ لم
تُحِبُّونِي
يا قَوم إِن حَصاتي ذاتُ مَعْجَمَةٍ ... على العَدُوّ فخلّوهم وخَلُّونِي
وقال آخر:
لَئن طِبتَ نفساً عن ثَنائيَ إنني ... لأَطيَبُ نفساً عن نَداك على عُسْرِي
فلَستُ إلى جَدْواك أَعظَم فاقةً ... عَلَى شِدّة الإعسَارِ منك إِلى
شُكْرِي
وروى الحَزَنْبَل عن أبي الأعرابي قال: مَدَح زياد الأعجم بعض العمّال
فحرمه ورأى لكنته فاستحقره، فدخل فأنشده:
وكنتُ إذا مَا عامِلٌ عَقَّ أُمَّه ... وَلم يَحْمها مِنِّي أَبحتُ
حِمَاهُما
كسَوتُهما بُرْدَينٍ من يَمَنِيةٍ ... إذا أُلبِسَا كانَا بَطِيئاً
بِلاَهُما
وأجهل الناس في ارتفاع منزلته، من ظنّ أنّ عِرضه في خفارة
قُدرته، وأن المُقدم عليه مُتعرض لنكيره، وخير من هذا الظن أن يحتمل ألم
مُفارقة المال ببعض الميسور، حتى لا يقرف بشيء لا غاسل له، ولا نافح عنه؛
ما الذي ربح اليزيدي حين آسد الشاعر الذي حرمه على نفسه حتى قال فيه شيئاً
شافياً لغليله منه بما بقي على أُست الدهر، وذلك قوله:
بَنو اليَزيديّ في أدبارهم شعَرٌ ... قد شابَ ممّا عليه تُحلَبُ الكَمَرُ
أَمَّا حُبيْشَةُ منهم فهُو ممتَحَنٌ ... من البغاء بما لم يمتَحَن بَشَرُ
بوُدّه أَن كلَّ الناسِ من حُمُرٍ ... وكلَّ جَارحة في جِسْمِه ذَكَرُ
والله للخروج من الطّارف والتّالد أسهل من التعرّض لهذا القول والصبر عليه
وقلّة الاكتراث به، ولهذا بكت العرب من وقع الهِجاء كما تبكي الثَّكْلى من
النساء، وذلك لشرف نفوسها ونزاهتها عن كل ما يتخوَّن جمالها ويعيب فعالها.
ومما يُختَل به الرئيس ويَذهل عليه أنه ينظر إلى جماعة بين يديه قد أحسن
إلى كلّ واحد منهم وقرّبه وأعطاه واختصّه بشيء وأنابه بحال، وإذا رأى
واحداً بعد هؤلاء لا نباهة لقدره، ولا جهارة لمنظره، ولا شُهرة لاسمه
ومنصبه حقَره، وثنى طرْفه عنه، وأغضاه دونه، ولم يهشّ لذكره ورؤيته،
واعتقد أنه ليس بذي محلٍّ يبالي به، ولا يبين في غمار الباقين؛ أو يجب على
ذلك المحروم أن يذكره بما هو أغلب عليه، وأشهر عنه، وأن يعدَّ نيل غيره
كرماً قد عمَّ، وأن كان إخفاقه وحده لؤماً قد خص؟ وهذا موضع يُشكِل
قليلاً، وتطول فيه الخصومة بين الآمل والمأمول، على أن الكرم والاحتجاج لا
يجتمعان، واللُّؤم والاحتيال لا يفترقان؛ وقد ألمَّ الشاعر بطرف من هذا
المعنى بقوله:
إِن تكلَّمتُ لم يكُن لكلامي ... موقعٌ والسكوتُ ليس بمُجْدِي
فأَبنِ لي أَكُلُّ هذا التواني ... في جَميع الإِخوان أَم فيَّ وحْدِي
أَم ترى ما اصطنَعته عند غيري ... واجب أَن أَعدَّه لك عِندي
والذي أقول غير محتشم ولا مراقب: أنّ السؤدد لا يكون إلا باحتمال خِصال من
الصَّبر والحِلْم والتكَرُّم والبذل والعَطاء والتفقُّد، وهنّ أثقل مما
يُعانيه الزائر بأمله، والفقير برجائه، والشاعر بطَمَعه، والمُنتجِع
بزيارته؛ اللّهم إلا أن يكون السّيد يجري في هذه الأخلاق والشِّيم على
الهوى فيُعطي من كان روحاً عنده، وأحلى شمائل وألطف فضلاً، وأعبر قولاً،
فهذا ليس عليه من ثقل السُّؤدد شيء، لأنه قد ميّز ما يخفّ عليه مما يثقل،
وما يتصل بنفسه مما ينبو عنه، وما هذا السؤدد ما قال أبو الأسود الدِّبلي
لعُبيد الله بن زياد: إنك لن تسُود حتى تصبر على سرار الشيوخ البُخر، وهذا
الكلام كالميل، وقال الشاعر،
لا تحسِب المجدَ تَمراً أَنت آكِلُه ... لن تِبْلُغَ المجدَ حتى تلعَقَ
الصَّبِرا
وقيل لعديّ بن حاتم: مَن السيد؟ قال: الأحمق في ماله، الذّليل في عِرضه،
المُطّرح لحقده، المعْنيّ بأمر جماعته؛ فليس يسود المرء إلا بعد أن يسهر
من أول ليله إلى آخره فِكراً في قضاء الحقوق، وكفّ السَّفاه، وازدِراع
المحبّة في القلوب، وبعث الألسنة على الشُكر؛ وفي الجملة من جهل حقك، فليس
يلزمك أن تعترف بحقه، ومَن لم ينظر فيما لك عليه، لم يجب عليك أن تنظر
فيما له عليك؛ وقد قال رسوله صلّى الله عليه: " لا خيْر لكَ في صُحبَة مَن
لا يَرى لك مثلَ ما ترى له " .
وقد قيل تواضَع للمُحسن إليك وإن كان عبداً حبشياً، وانتصف ممن أساء إليك
وإن كان حُراً قُرشياً؛ ومن صفات الكريم ما قال الشاعر:
وإنّ الكريمَ من تلفَّت حولَه ... وإِن اللَّئيم دائمُ الطَّرْف أَقوَدُ
وقال آخر:
لَحا الله أكبانا زِناداً وشَرَّنا ... وأَيسَرنا عن عِرض والِده ذَبّا
رأيتُك لما نِلتَ مالاً وعَضَّنا ... زمانٌ تَرى في حدّ أنيابه سَغْبا
جعلتَ لنا ذنباً لتمنع نائلاً ... فأَمسِك ولا تجعَل غِناك لنا ذَنباً
وقال آخر:
نالَ الغِنا بعدَ فقْرٍ فاستغاثَ به ... كما استغاثَ بباقي ريقِه الشَّرِقُ
وإذا احتججتُ بالعيان في وصف هذين الرّجلين في الكرم واللؤم فقد
رفعت المِرْية، وإذا أقمت الشاهد على الدّعوى فقد منعت من اللائمة، وإذا
رأيت الضرورة فقد بلغت الغاية؛ وأيُّ خفقةٍ للقلب بعد اليقين، وأيُّ وحشةٍ
للنفس بعد الاستصبار، أم أيُّ بقية على المُحتج إذا وصل البرهان، أم كيف
يُستحيا في الحق وإن كان مُرّاً، أم كيف يُعتذَر من الصّدق وإن كان موجعاً.
هذا ما لا يُكلّفه حكيم، ولا يأمر به مُرشد، ولا يحثّ عليه ناصح.
وهذا مبدأ أخذي في حديث ابن عبّاد على ما يتّفق من تربيته ووضعه، غير آخذٍ
في أُهبةٍ، ولا مُحتفلٍ بتقدِمة.
فأول ما أذكر من ذلك ما أدلُّ به على سَعَة كلامه، وفصاحة لسانه، وقوة
جأْشه، وشدة مُنَّته، وإن كان في فحواه ما يدل على رقاعته وانتكاث
مَريرته، وضعف حوله، وركاكة عقله وانحلال عقده.
لمّا رجع من هَمَذان سنة تسع وستين وثلاثمائة بعد أن فارق حَضرَة عضُدِ
الدّولة استقبله الناس من الرَّيّ وما يليها، واجتمعوا بِساوَةَ، ودونها
وفوقها، وكان قد أعدَّ لكل واحدٍ منهم كلاماً يلقاهُ به عند رؤيته وأين
كانوا يقعون منه، وأين كانوا يبيتون عندهُ؛ وهذا الذي ذهب به في الإعجاب
والكِبر، وبعثه على احتقار الناس، وتركه في التّيهِ المُضلّ.
فأول من دنا منه القاضي أبو الحسن الهمذاني وهو من قرية يقال لها
أَسَدآباد، فقال له: أيها القاضي! ما فارقتُك شوقاً إليك، ولا فارقتني
وَجْداً عليك، ولقد مرَّت بعد ذلك مجالس كانت تقتضيك وتُحظيك وترتضيك؛ ولو
شهِدتَني بين أهلها وقد علوتُهم ببياني ولساني وجدلي، لأنشدتُ قول حسّان
بن ثابت في ابن عباس ورأيتني أولَى به منه، فإنَّ حسّان قال:
إذا ما ابنُ عبّاس بَدا لك وَجهُه ... رأيتَ له في كلّ مجمعة فضْلا
إذا قال لم يترُك مقالاً لقائل ... بملتَقَطاتٍ لا تَرى بينها فصْلا
كفى وَشفى ما في النُّفوسِ فلَم يَدَع ... لذي إِرْبةٍ في القَوْل جدّاً
ولا هَزْلا
سَموتَ إلى العَلْيا بغيْر مشقةٍ ... فنِلتَ ذُراها لا دَنيّاً ولا وَغْلا
ولذكرت أيها القاضي قول الآخر وأنشدته: فإنه قال فيمن وقفَ موقفي، وقرفَ
مقرفي، وتصرَّف مُتصرفي، وانصرف مُنصَرَفي، واغتَرف مُغْتَرَفي:
إذا قال لم يَترُك وَلم يَقِفْ ... لِعيٍّ ولَم يَثْنِ اللّسانِ على هُجْر
يُصَرّف بالقول اللّسانَ إذا انتَحى ... وينظرُ في أَعطافِهِ نظَرَ
الصَّقْرِ
ولقد أودعت صدر عضد الدولة ما يطول به التفاته إليّ، ويُديم حسرته عليّ،
ولقد رأى ما لم يرَ قبله مثله، ولا يرى بعده شكله؛ فالحمد لله الذي أوفدني
عليه على ما يَسُر الوليّ، وأصدرني عنه على ما يسوء العدوّ.
أيها القاضي كيف الحال والنفس، وكيف الإمتاع والأُنس، وكيف المجلس
والدَّرس، وكيف القرص والجرْس، وكيف الدَّس والدعْس، وكيف الفرس والمَرْس
وكاد لا يخرج من هذا الهذيان لتهيّجه واحتدامه، وشدة خَيلائه وغُلوائه.
والهمذاني مثلُ الفارة بين يدي السِّنَّور قد تضاءل وقُمؤ لا يصعَد له
نفَس إلاّ بنزع تذلُّلاً وتقلُّلاً، هذت على كِبره في مجلسه مع نذالته في
نفسه.
ثم نظر إليّ الزَّعفرانيّ رئيس أصحاب الرأي فقال: أيها الشيخ! سرَّني
لقاؤك وساءني عناؤك وقد بلغني عُدَواؤك وما خيَّله إليك خُيلاؤك وأرجو أن
أعيش حتى يُردّعليك غُلواؤك؛ ما كان عندي أنك تُقدم على ما أقدمت عليه،
وتنتهي في عداوتك لأهل " العدْل والتوحيد " إلى ما انتهيت إليه؛ ولي معك -
إن شاء الله - نهارٌ له ذيل، وليل يتبعه ليل، وثُبورٌ يتّصل به ويل، وقطْر
يدوم معه سَيْل؛ (وَسَيَعْلَمُ الكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّار).
قال الزَّعفرانيّ: " حَسْبُنا اللهُ ونِعْمَ الوَكِيلً " .
ثم أبصرَ أبا طاهر الشيخ الحنفي فقال:
أيها الشيخ! ما أدري أ أشكوك أم أشكو إليك، أما شكواي منك فلأنّك
لم تكاتبني بحرف، حتى كأنّا لم نتلاحظ بطرف، ولم نتحافظ على إِلف، ولم
نتلاق على ظرف؛ وأما شكواي إليك فهو أنّي ذممتُ الناس بعدك، وذكرت لهم
عَهْدك، وعرضت بينهم وُدَّك، وقدحت عليهم زَنْدك، ونشرت عندهم غرائب ما
عندك؛ فاشتاقوا إليك بتشويقي، واستصْفَوك بتزْويقي، وأثنَوا عليك يتنميقي
وترويقي؛ وهكذا عمل الأحباب إذا تناءت بهم الرّكاب، والتوَت دونهم
الأعناق، واضطرمت في صدورهم نارُ الاشتياق.
فالحمد لله الذي أعاد الشعب ملتئماً، والشمل منتظماً، والقلوب وادعة،
والأهواء جامعة؛ حمداً يتّصل بالمزيد، على عادة السادة مع العبيد، عند كل
قريب وبعيد.
ثم التفت إلى ابن القطّان القزويني الحنفي، وكان من ظرفاء العلماء، فقال:
أيها الشيخ! كدت والله أحلم بك في اليقظة، وأشتمل عليك دون الحفظة، لأنك
قد ملكت ني غاية المكانة والحظوة؛ والله ما أسَغتُ بعدك ريقاً إلاّ على
جَرَض، ولا سلكتُ دونك طريقاً إلا على مضَض، ولا وجدتُ للظَّرف سوقاً إلاّ
بالعرض. سقى الله ربعاً أنت ساكنه بنزاهتك، وطبعاً أنت طابته ببراعتك،
ومغرساً أنت نبْعُه بنباهتك، وأصلاً أنت فرعه بفقاهتك.
وقال للعباداني: أيها القاضي! أيَسُرُّك أن أشتاقك وتسلو عني، وأن أسأل
عنك فتنسلّ مني، وأن أُكاتبك فتتغافل، وأُطالبك بالجواب فتتكاسل؛ وهذا ما
لا أحتمله من صاحب خُراسان، ولا يطمع منّي فيه ملك بني ساسان؛ متى كنتُ
منديلاً ليد؟ ومتى نزلت على هذا الحدّ لأحد؟ إن انكفأتَ إليّ بالعُذر
انكفاء، وإلاّ اندرأت عليك بالعذل اندراء، ثم لا يكون لك معي قرار بحال،
ولا يبقى لك بمكاني استكثار إلا على وبالٍ وخبال.
ثم طلع أبو طالب العلوي فقال: أيها الشريف! جعلت حسناتك عندي سيئات، ثم
أضفت إليها هَناتٍ بعد هنات، ولم تفكر في ماضٍ ولا آت، أضعت العهد وأخلفت
الوعد، وحققت النحس وأبطلت السَّعد؛ وحُلت سراباً للحيران، بعد ما كانت
شراباً للحرَّان، وظننت أنك قد شبعت مني، أو اتعضت عني، هيهات! وأنَّى لك
بمثلي، أو بمن يعثر في ذيلي، أو له نهارٌ كنهاري أو ليلٌ كليلي؟
وهَل عائضٌ مِنّي، وإِن جلَّ، عَائضُ
أنا واحد هذا العالم، وأنت بما تسمع عالم؛ لا إله إلا الله، وسبحان الله.
أيها الشريف! أين الحق الذي وكَّدناه أيام كادت الشمس عنا تزول؟ والزَّمان
علينا يصول، وأنا أقول، وأنت تقول، والحال بيننا يحول؟ سقى الله ليلة
تشييعك وتوديعك، وأنت متنكر تنكراً يسوء الوليّ، وأنا مفكّر تفكّراً يسُرّ
العدو، هذا ونحن متوجهون إلى ورامين خوفاً من ذلك الجاهل المهين، يعني
بالجاهل المهين ذا الكفايتين حين أخرجه من الريّ بعد أن ألَّب عليه وكاد
يُؤتى على نفسه الخبيثة، وهو حديث له فَرْش، وما أنا بصدده يمنع من
اقتصاصه، ولعله يجري على وجهه فيما بعد؛ ولقد ظلم بقوله، وكان بالجهل
والمهانة أحقّ، وسيَمر ما يدل على قولي ويُصحّح حكْمي، ويبيّن لك أنه لم
يكن معه إلا الجدُّ المساعد فقط، وباقي ذلك تشبُّع وإيهام وتمويه وكذِب
وبَهْتٌ ووقاحة.
ثم نظر إلى أبي محمد كاتب الشروط فقال: أيها الشيخ! الحمد لله الذي كفانا
شرّك، ووقانا عُرَّك، وصرف عنّا ضُرَّك، وأرانا فيحك وحرَّك؛ دببت الضرّاء
إلينا، ومشيت الخَمَر علينا، ونحن نَحيسُ لك الحَيس ونصفك باللَّبابة
والكَيس، ونقول ليس مثله ليس، وأنت خلال ذلك تقابلنا بالوَيْح والوَيْس؛
لولا أنك قَرحان لسقط العَشَا بك منّا على سِرحان.
وقال لابن أبي خراسان الفقيه الشافعي: أيها الشيخ! ألغيتَ ذكرنا عن لسانك،
واستمررت على الخلوة بإنسانك، جارياً على نسيانك، مُستهتراً بفتيانك
وافتنانك، غير عاطفٍ على إخوانك وأخدانك؛ لولا أنني أرعى قديماً قد أضعته،
وأُعطيك من رعايتي ما قد منعته، لكان لي ولك حديث، إما طيّب وإما خبيث؛
خلَّفتك محتسباً فخلفت مكتسباً، وتركتك آمراً بالمعروف فلحِقتُك راكباً
للمنكر، قد يفيل الرأيّ ويخيب الظن، ويكذب الأمل، وقد قال الأول:
أَلا رُبَّ من تغتَشُّه لك ناصِحٌ ... ومؤتَمنٍ بالغَيْب وهو ظَنِين
ثم نظر إلى الشادياشي فقال: يا أبا عليّ! كيف أنت وكيف كنت؟ فقال: يا
مولانا
لا كنتُ إِن كنت أدري كيف كنت ولا ... لا كنتُ إن كنتُ أَدري كيف لم أَكن
فقال: أغرب يا ساقط يا هابط، يا من يذهب إلى الحائط بالغائط، ليس
هذا من نحت يدِك ولا هو مما نشأَ من عندك، هذا لمحمد بن عبد الله بن طاهر،
أوله:
كتبت تسأَل عني كيف كنتُ وما ... لاقيت بعدك من غمّ ومن حَزَنِ
لا كنتُ إِن كنتُ أَدري كيف كنتُ ولا ... لا كنتُ إِن كنتُ أدري كيف لم
أَكنِ
وكان ينشد وهو يلوي رقبته، ويجحظ حَدَقته، ويُنزي أطراف منكبه ويتسايل
ويتمايل، كأنه (الَّذِي يَتَخَبَّطَهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ).
ثم قال: يا أبا علي! لا تُعوِّل على اير في سراويل غيرك، لا ايرَ إلا ايرٌ
تمَطّى تحت عانتك، فإنك إن عولت على ذلك خانك وشانك وفضح خانك ومَانَك.
ثم نظر إلى غلامٍ قد بقل وجهه كان يُتَّهم به على الوجه الأقبح، فالتوى
وتقلقل، وقال: ادْنُ يا بُنيّ! كيف كنت؟ ولم حملت على نفسك هذا العناء؟
وجهُك هذا الحسن لا يبتذل للشحوب، ولا يُعرض لِلَفحات الشمس بين الطلوع
والغروب، أنت يجب أن تكون في بِذْلة بين حجَلةٍ وكِلّةٍ، تُزاح بك العلّة،
وتُعلا فيك القُلّة، وتُشفى منك الغُلَّة.
هذا آخر حديث الاستقبال، وقد حذفت منه أشياء كثيرة من رقاعاته، لأنَّ
الغرض غير مقصور على فنٍّ واحد من حديثه.
وقال يوماً في دار الإمارة لفَيْرُوزَان المجُوسي، وكان الخرائطيّ حاضراً،
في شيء نابذه عليه؛ إنما أنت مجش محش لا تهش ولا تبش ولا تَمْتِش.
فقال له فيروزان: أيها الصّاحب! برئت من النار إن كنت أدري ما تقول، إن
كان من رأيك أن تشتمني فقُل ما شئت بعد أن أعلم، فإن العِرض لك، والنَّفس
فِداؤك، لست من الزّنج، ولا من البربر، ولا من الغُزّ، كلِّمنا بما نعقل
على العادة التي عليها العمل؛ والله ما هذا من لُغة آبائك الفُرس، ولا لغة
أهل دينك من هذا السَّواد؛ فقد خالَطْنا الناس فما سمعنا منهم هذا
النَّمط، وإني أظن أنك لو دعوت الله بهذا الكلام لما أجابك، ولو سألته لما
أعطاك، ولو استغفرت الله به ما غفر لك؛ وحقيق على الله ذلك.
فقال الخرائطيّ: أيها الصاحب! والله لقد صدق فلا تغضب، فليس كل من وثق
بأنه لا يُراجع في قوله رَكِب ما يُحَمَّقُ فيه شاهداً أو غائباً.
فقام عنهما خَزْيان يُردّد ريقه حِقداً عليهما، وكان ذلك سبباً كبيراً في
فساد أمرهما.
وقلتُ للزّعفراني الشاعر، وكان من أهل بغداد: اصدُقني أيها الشيخ عن هذا
الإنسان، كيف وجدته في طول ما عجمت عودَه، وتصفّحت أخلاقه، وخبرت دِخلته.
فقال: وجدته كليل الكرم، حادّ اللؤم، رقيع الظاهر، مُريب الباطن، دنِس
الجيب، مُثرياً من العيب، كأنه خلق عبثاً مما مُلي خُبثاً؛ سفهه ينفي حكمة
خالقة، وغِناه يدعو إلى الكفر برازقه؛ وأنا أستغفر الله من قولي فيه
ونفاقي معه؛ ولعن الله الفقر فهو الذي يُحيل المروءة، ويقدح في الديانة؛
ولو كان لي ببغداد قوتٌ يحفظ عليَّ ماء الوجه ما صبرت على هذا الرّقيع
البارد المطاع ساعة، ولكن ما أصنع قد قلّبت أمري ظهراً لبطن، مالي إلى
الرزق باب إلاّ منه، وأنشد:
وَالرّزق كالوَسميّ رُبَّتَما عَدا ... روضَ القَطا وسقَى مَهامِه جِلّقِ
فإذا سمعت بحوَّّلٍ متأَله ... متأَدب فهو الذي لم يُرزَقِ
والرِّزقُ يخطيء بابَ عاقل قومه ... ويَبيتُ بَواباً لبابِ الأَحمقِ
وأنشد أيضاً:
الرّزقُ قد يأتيك في وَقتِه ... والحرصُ لا يُغني ولا يُجدي
كم قاعدٍ يبلغ مأْمولَه ... وَطالبٍ مضطرب يُكدي
فاسترزِق الرازقَ مِن فضلِه ... وارضَ بما يُوليك من رفدِ
وثِق بإِحسانٍ له واسعٍ ... فهكذا عاداتُه عندي
وأنشد القرمسيني قال: أنشدنا عليُّ بن سليمان الأخفش لشاعر:
قد يُرزَق المرء لم تتعَب رواحلُه ... ويُحرم الرزقَ من لم يُؤتَ من تَعَب
يا ثابتَ العقل كم عايَنْتَ ذا أَدب ... الرزقُ أَعدَى له من ثابت الجَرَب
وإِنني واجدٌ في النّاس واحدةً ... الرزقُ والنُّوكُ مقرونان في نسب
وخصلةً قلَّ فيها من يُنازِعُني ... الرزقُ أَروَغُ شيءٍ عن ذوِي الأَدبِ
وقلت للمسيَّبي:ما قولك في ابن عباد؟
فقال: له في الخلاعة قرآن مُعجر، وفي الرّقاعة آية مُنزلة، وفي
الحسد عرق ضارب، وفي الكذب عارٌ لازب؛ لا ينزع عن المساوي إلا مَلَلا، ولا
يأتي الخير إلا كسلاً؛ ظاهره ضلالة، وباطنه جهالة، وليس له في الكرم
دلالة، ولا في الإحسان إلى الأحرار آلة؛ فسبحان من خلقه غيظاً لأهل الفضل
والأدب، وأعطاه فيضاً من المال والنشب! وقلت لأبي بكر الخوارزمي الشاعر،
وكان قد خَبَره: كيف وجدت الصاحب، وقد أعطاك وأولاك وقدَّمك وآثرك، وسفر
لك إلى عضد الدولة، وهو اليوم شاه الملوك، حتى ملأتَ عيابك تِبراً،
وحقائبك ثياباً، ورواحلك زادا؟ فقال: دعني مما هنالك، والله إنه لخواز في
المكارم، صبار على الملائم، زحّاف إلى المآثم، سمّاع للنمائم، مِقدام على
العظائم؛ يدعو إلى " العدل والتوحيد " ، ويدّعي " الوعد والتخليد " ، ثم
يخلو باستعمال الأُيُور، ويشتمل على الفسوق والفجور، ويُمسي وهو بُور
ويُصبح وما على وجهه نور.
وكان الخوارزمي من أفصح الناس، ما رأينا في العجم مثله، وإنما نوَّله
الصاحب ما نوّله، وخوّله ما خوّله، لأنه كان أذكاه عيناً على محمد بن
إبراهيم صاحب الجيش بنيسابور، واستملى فيه أخبار المشرق، وبهذا المعنى
استدرَّ له من ملِك بغداد بوساطة ابن يوسف، وكان الظاهر أنه إنما يعطيه
لأدبه، ويجيزه لشعره، ويصطفيه لفضله.
ولقد قات للزعفرانيّ: أرى الخوارزميّ سيّءَ الرأي في ابن عبّاد مع ما يصل
إليه منه، فما السبب؟ فقال: ابن عبّاد سيءُ السياسة لصنائعه، وذلك أنه
يعطي الإنسان عطية ما، ثم يبلوه بجفاءٍ يتمنّى معه لَقْط النّوى من
السِّكك، والمصطنع الكريم هو الذي يكون اصطناعه بلسانه فوق اصطناعه بيده؛
وإني أحدثك ببعض ما عامل به الخوارزمي ليصحّ لك القياس عليه، والتعجب منه.
حضر الخوارزمي يوماً، وجرى حديث القَافة، فقال الخوارزمي: دخل محرز
المدْلجيّ على رسول الله صلى الله عليه ونظر إلى أقدام أُسامة، وزيد،
فقال: هذه أقدامٌ بعضها من بعض، وصحّف البائس كما يُصحّف الناس، العلماء
فمن دونهم، وكان ابن عبّاد على بركة، فما زال يدور حول البركة وهو يصفع
الخوارزمي ويقول: محرز؟ بحياتي؟ إلى أن رعَف الخوارزمي فتنحى وخرج.
فهذا وما داناه هو الذي كان يُفسد به ما يفعله من الخير والبر.
وحدّثني بذكْوِ أبي بكرٍ عيناً بخراسان أبو الطيب النصراني، وكان علي
السرِّ عند مؤيّد الدولة وكان يعرف من مخازي ابن عبادٍ عجائب؛ سمعته يقول:
لو بُحتُ بما في نفسي من حديث هذا المأبون لتصدَّع الجبل، ولتقلّع
الجَندَل.
وكان ابن عبّاد شديد السفه عجيب المناقصة، سريع التحوّل من هيئة إلى هيئة،
مُستقبلاً للأحرار بكل فرْية وفاحشة؛ كان يقول للإنسان الذي قد قدم عليه
من أهل العلم: تقدّم يا أخي! وتكلّم، واستأنس، وافترِح، وانبسِط، ولا
تُرع، واحسبني في جوف مرقعة، ولا يهولك هذا الحشم والخدَم، وهذه الغاشية
والحاشية، وهذه المرتبة والمسْطَبة، وهذا الطارق والرِّواق، وهذه المجالس
والطنافس؛ فإن سلطان العلم فوق سلطان الولاية، وشرف العلم أعلى من شرف
المال، فليفرح روعك ولينعم بالُك، وقُل ما شئت، وانصُر ما أردت، فلست تجد
عندنا إلا الإنصاف والإسعاف والإتحاف والإطراف، والمقاربة والمواهبة،
والموانسة والمقابسة، وعلى هذا التنزيل، ومن كان يحفظ ما يهذي به في هذا
وغيره؟ حتى إذا استقى ما عند ذلك الإنسان بهذه الزّخارف والحيل، وسال
الرجل معه في حدُوره على مذهب الثّقة، وركب في مناظرته، وردعه وحاجّه،
وراجعه وضاجعه وشاكعه ووضع يده على النكتة الفاصلة، والأمر القاطع تنمَّر
له، وتنغّر عليه، واستحصد غضباً وتلظّى لهباً وقال بعد وثبتين أو ثلاث: يا
غلام! خذ بيد هذا الكلب إلى الحبس، وضعه فيه بعد أن تصبّ على كاهله وظهره
وجنبيه خمس مئة عَصا؛ فإنه مُعاند ضدّ، يحتاج إلى أن يُشدّ بالقِدّ، ساقط
هابط، كلبٌ نبّاح، متعجرف وقَاح؛ أعجبه صبري، وغرّه حلمي، ولقد أخلف ظني،
وعدت على نفسي من أجله بالتوبيخ، وما خلق الله العصا باطلاً، ولا ترك خلقه
هاملاً.
فيُقام ذلك البائس على هذه الحال التي تسمَع، على أن مسموعك دون
مُشاهدتك لو شاهدت، ومن لم يحضر ذلك المجلس لم يرَ منظراً رفيعاً ورجلاً
رقيعاً؛ وقد عامل بما وصفتُ الحريري غلام ابن طرارة والجامدي الشاعر
الوارد عليه من البصرة، وأبا زيد الكلابي وغيرهم.
وكان أبو الفضل أعني ابن العميد إذا رآه يقول: أحسَب أن عينيه رُكّبتا من
زئبق وعنقه عُمل بلولب.
وصدق، لأنه كان ظريف التّثني والتلوّي شديد التفكّك والتفتّل كثير التعوّج
والتموّج، في شكل المرأة المومسة والفاجرة الماجنة، والمخنَّث الأشمط.
وسمعت أبا الفضل الهَرَوي يقول له يوماً: لو وُضع في خزانة الكتب للوقف
شيءٌ من الطبّ لكان ذلك باباً من المنافع لحاضرة والفوائد المجّلة والخير
العامّ.
فقال على حدّته وجنونه: الطبّ - يا أبا الفضل - سُلَّم الإلحاد، ولقد
أسررت في هذا القول حسواً في ارتغاءٍ، أنت مُهندس، وأنت متّهم، ويكفي منك
في هذا المعنى ما هو دون هذا.
فانخزل الهروي وكان جباناً، وأخذ يتلافى ما فرط منه.
قال أصحابنا بالريّ: وكيف يسوغ له أن يقول هذا، وهو يُشاور الطبيب في كل
غداة، ويعتمد على الطبّ في كلّ عارض، ويجمع الكتب فيه، ويرجع إليه؛ وليس
هذا بأعجب من عيبه لعلم النجوم وذمِّه لأهله، وهو لا يُفارق التقويم، ولا
يخلو يوماً من النَّظر فيه مرّات؛ لأنه كان لا يركب إذا وجد نحساً، هذا
على تقليده فيه، لأنه ما كان يعرف حرفاً من علم النُّجوم، لا على طريقة
مَن ينظر في أحكامه، ولا على مذهب من يختاره لهيئته، فهل رأيت بهتاً أشدّ
من هذا؟ ومناقضة أقبح من هذا؟ يذمّ شيئاً في الظاهر، ثم يحبه في الباطن،
ويزهد غيره في شيء وهو يؤثره.
وكان من ضعف عقله يقول: يجوز أن يكون الفلك من سَلْجَم أو جَزَر أو فجل؛
قال هذا للصاغاني أبي حامد ونحن حضور، وهو مع هذا العقل السّخيف يطلب كتب
الأوائل ويجمعها، وينظر فيها، ويشتهي أن يفتح فاتح عليه شيئاً منها في
السرّ، وعلى وجه التهجين لا على وجه التَّقبُّل، ويقول في أبي حسن
العامري: قال الخرائي كذا وكذا، وإذا خَلا نظر في كتبه ومصنّفاته، وكان
أخذها من أبي الحسن الطبري، طبيب رُكن الدّولة، وكان مع هذا المذهب الذي
يُدِلّ به ويُسمّيه " العدل والتوحيد " قليل التوجُّه إلى القبلة، قليل
الركوع والسُّجود، وكان مع حفظه الغزير، عليه مؤونة في تلاوة آية من كتاب
الله عزّ وجلّ، إذا أراد أن يستدل بها في المناظرة والجدل، أو يذكر وجهاً
من وجوهها في المذاكرة، ولم يكن عليه طابع العبادة، ولا سيّما المتألّهين،
وكان مع هذا سفّاكاً للدماء، قتّالاً للنُّظراء والأكفاء، وكان شديد الحسّ
لأهل الفضل والدراية، ولأصحاب الحفظ والرواية، وكان جلّ حسده لمن كتب
فأحسن الخطّ وأجاد اللفظ، وتأتى للرسم وملّح في الاستعارة، وكان إذا سمع
من إنسان كلاماً منظوماً، ومعنىً قويماً، ولفظاً مسجوعاً، ونثراً مطبوعاً،
وبياناً بليغاً، وغرضاً حكيماً انتقض طِباعه وذهب عليه أمره وتبدّد حلمه
وزال عنه تماسكه والتهب كأنه نار، واضطرب كأنه شَرار، وحدّث نفسه بقتله أو
نفيه أو إغراقه وإبعاده وحرمانه.
قلت للتَّميمي الشاعر المصريّ بالرغيب: كيف ترى هذا الرجل أعني ابن عبّاد؟
فقال: طويل العنان في اللؤم، قصير الباع في الكرم، وثّاباً على الشرّ،
مُقْعداً عن الخير، كافراً بالنّعم، متحرّشاً بالنّقم، جبّاهاً بالمكروه،
سفيهاً في الجملة، خليعاً في التفصيل.
قلت: أين هو من صاحبكم بمصر أعني ابن كِلّس؟ فقال: ذاك رجل له دارُ ضيافة،
وله زوّارٌ كالقطر، لا يعرف مَحْكاً ولا لجاجاً ولا مجادلة، ولا كياداً
ولا مُخاتلة، يعطي على القصد والتأميل، والرجاء والتوجه، والطمع والطلب،
وسائر الوسائل عنده، بعد هذه الأوائل، فضلٌ يستحق به الزيادة، وليس هناك
امتحان ولا مُحاسبة ولا احتجاج ولا تعيير، المالُ مصبوب، والخازنُ قائم،
والمُفرّق مُجزِّف، والنّداء عالٍ، والواصل موصول، والمؤمَّل مشكور،
والرّاحل شاكر؛ وِزارة ذاك نيابةٌ عن خِلافة، ووزارة هذا خلافة عن عَمالة.
هل ترى هاهُنا صلةً ترتفع عن مئة درهم إلى ألف؟
أَليس أنبل من وردَ عليه البديهي وهو شيخه في العروض، وعنه أخذ
القوافي، وبفتحه وهدايته قال الشعر؟ هل زاده في طول مُقامه إلى رحيله على
خمسة آلاف درهم تفاريق؟ وإن أَقلّ ضيف بمصر يصير إليه مثل هذا في أول يوم.
وقد سألت جماعة من سادة الناس عنه، وحصّلت عن كل واحد منهم جواباً يمر بك
فيما تستقبل، وأذكرها هنا أشياء حدّثني بها بطانته وخدمه.
حدثني الجرفادقاني أبو بكر وكان كاتب داره، قال: يبلغ من سُخنَة عينِ
صاحبنا أنه لا يسكت عما لا يعرف، ولا يسأم نفسه فيما لا يفي به ولا يكمل
له، ويظن أنه إن سكت عنه فُطن لنقصه وإن اختال وموّه جاز ذلك وخفي واستتر
ولم يظهر، ولم يعلم أنّ ذلك الاحتيال طريقٌ إلى الإغراء بمعرفة الحال،
وصَدَق القائل: كاد المريب يقول: خُذُوني.
قات له: ما الذي حَداك على هذه المقدّمة؟ قال: قال لي في بعض هذه الأيام:
ارفع حسابك قد أخّرته وقصّرت فيه واغتنمت سكوتي وشغلي بتدبير المُلك
وسياسة الأولياء والجُند، والرَّعايا والمُدن، وما عليَّ من أعباء الدولة
وحفظ البيضة ومُشارفة الأطراف النائية والدَّانية باللسان والقلم، والرأي
والتدبير، والبسط والقبض، والإبرام والنَّقض، وما على قلبي من الفكر في
الأمور الظاهرة والغامضة؛ وهذا لعمري باب مُطمِع وإِمساكي عنه مُغْرٍ
بالفساد مُولع، فبادر عافاك الله إلى عمل حساب بتفصيل بابٍ بابٍ تُبيّن
فيه أمر داري، وما يجري عليه دخلي وخرجي.
قلت له: وهذا كله بسبب قوله هات حسابك بما تُراعيه؟ وصدق هذا الكاتب، كان
يأخذ طرفاً من الحديث فيمدُّه إلى الفَلَك بالغَثاثة والجهل والهذر.
قال أبو بكر: فتفرَّدتُ أياماً وحرَّرت الحساب على قاعدته وأصله والرسم
الذي هو مألوف بين أهله، وحملته إليه، فأخذه من يدي وأمرَّ عينه فيه من
غير تثبُّت أو فحص أو مسألة، ثم حذفَ به إليَّ وقال: أهذا كتاب، أهذا
تحرير، أَهذا تقرير، أَهذا تفصيل، أَهذا تحصيل؟ والله لولا أني قد ربّيتُك
في داري، وشغلت بتخريجك ليلي ونهاري، ولك حُرمة الصِّبا، وتلزمُني رعاية
الأبناء، لأَطعمتك هذا الطومار، وأَحرقتُك بالنفط والنار، وأَدّبت بل كل
كاتب وحاسب، وجعلتك مُثلةً لكل شاهد وغائب.
أمِثلي يُموّه عليه، ويُطمع فيما لديه، وأنا خلقت الكتابة والحِسابة؛
والله ما أنام ليلةً إلاّ وأحصّل في نفسي ارتفاع العراق ودخل الآفاق؛
أَغَرَّك مني أني أجررتُ: رَسَنَك، وأخفيتُ قبيحك وأبديتُ حَسَنك؟ غيِّر
هذا الذي رفعت، واعرف قبلُ وبعدُ ما صنعت، واعلم أنك من الآخرة قد رجعت
فَزِد في صلاتك وصَدقتك، ولا تعوّل على قِحتك وصَلابة حَدَقتِك.
قال: فوالله ما هالني كلامه، ولا أَحاك في هذيانه، لأني كنت أعلم جهله
بالحساب، ونقصه في هذا الباب، فذهبتُ، وأفسدتُ وقدّمتُ وأخَّرت، وكايدت
وتعمّدت؛ ثم ردَدتُّه إليه فنظر فيه، ثم ضحك في وجهي وقال: أحسنت بارك
الله عليك، وهكذا أردت، وهذا بعينه طلبت ولو تغافلتُ عنك أول الأمر لما
تيقَّظت في الثاني.
فهذا كما ترى أعجبَ منه كيف شئت.
ومن رقاعاته أيضاً: سمعته يوماً يقول: وقد جرى حديث الأبهريّ المتكلّم،
وكان يُكنى أبا سعيد، فقال: لعن الله ذلك الملعون المأبون المأفون، جاءَني
بوجه مكَلحَّ، وأنف مُفلطَح، ورأس مسَفّح، وذقن مسَلّح، وسُرْم مفتّح،
ولسان مبلّح، فكلَّمني في مسألة الأصلح، فقلت له: اغرب عليك غضبُ الله
الأترح، الذي يلزم ولا يبرح.
وشتم يوماً رجلاً فقال: لعن الله هذا الأهوج الأعوج، الأفلج الأفحج، الذي
إذا قام تحلج، وإذا مشى تدحرج، وإن عدا تفجفج.
بالله يا أصحابنا حدثوني، أهذا عقل رئيس، أو بلاغة كاتب، أو كلام متماسك؟
لم تجنّون به، وتتهالكون فيه؟ وتغيظون أهل الفضل به؟ هل هناك إلاّ الجدّ
الذي يرفع مَن هو أنذل منه، ويضع مَن هو أرفع منه؟ ولقد حدثت بهذا الحديث
أبا السلم الشاعر، فأنشدني لشاعر:
سبحان من أَنزل الدنيا منازِلها ... وصيَّر الناسَ مَشنوءاً ومومُوقا
فَعاقِلٌ فَطِن أَعيَتْ مذاهبُه ... وجاهلٌ خَرِقٌ تَلقاه مَرزوقا
كأَنّه من خليج البحر مُغترف ... ولم يكن بارتزاق القُوت محقوقا
هذا الذي ترك الأَلبابَ حائرةً ... وصَيَّر العاقل النحرير زنديقا
وحدثني المأموني عند روايتي هذا الحديث: سمعته أنا يقول على غير
هذا الوجه، قال: جاءَني فلان بهامة مسطَّحة، وأرنبة مفلطحة، ولحية
مسرَّحة، وقفحة مسلحة، وجبهة موقّحة، وجملة مقبّحة، يناظرني في المصلحة،
فهممت والله أن أصلبه على باب المسْلحة. وباب المسلَحة بالري سوقٌ معروفة.
وهذا الكلام الثاني هو الأول يشقق ويؤذي، ويصيح ويهذي، ويوهِم ويدّعي،
وقاحةً وجهلاً وازدراء للناس، وحقراً لكل من يرى من أهل الفضل والأدب،
والحرية والحسب.
وكان كَلَفه بالسَّجع في الكلام والقلم عند الجدّ والهزل يزيد على كلف كلّ
من رأيناه في هذه البلاد.
قلت للمسيّبي: أين يبلغ في عشقه للسَّجع، قال: يبلغ به ذلك أنه لو رأى
سجعة تنحلّ بموقعها عُروة الملك، ويضطرب بها حبلُ الدولة، ويحتاج من أجلها
إلى غُرْمٍ ثقيل وكلفةٍ صعبة، وتجشّم أمور، وركوب أهوال، لكان يخفّ عليه
أن لا يفرج عنها ويخلّيها، بل يأتي لها ويستعملها، ولا يعبأ بجميع ما وصفت
من عاقبتها.
وقال علي بن قاسم الكاتب: السجع لهذا الرجل بمنزلة العَصَا للأعمى،
والأعمى إذا فقد عصاه فقد أُقعد، وهذا إذا ترك السّجع فقد أُفحِم.
وقاتُ للخليلي: كيف كان ابن العميد أبو الفضل يقدّم هذا ويرشّحه وهذا عقله
ولفظه وشمائله؟ فقال: كان يسترفعه ويضحك منه ولا يغتاظ لأنه كان تحت
تدبيره. والرّقاعة الخالية من القدرة مقبولة، وإنما تضاعف اليوم حديثُه في
الرّقاعة لأنه أصبح بسيط اللسان بالدولة، مُطاع الأمر في القريب والبعيد؛
ونعوذ بالله من جنون موصول بانقياد الأمور وطاعة الرجال. وكان يقول: هو مع
هذا الطيش والخفّة، والتفتل والتثني أفضلُ من أبيه؛ فإن أباه كان ثورا
خوّاراً، وحماراً نهّاقاً.
وكان أيضاً يقدَح ابنه أبا الفتح به، ويبعثه على الحركة والنُّطق، وكان
أيضاً مظنوناً به وهو غلام ما بقل وجهه.
قال: وأسباب الجدّ عجيبة، وكما لا يدري الإنسان من أين يُخفق كذلك لا يدري
من أين ينال.
فقلت للخليلي: أما كان ابن العميد يسمع كلامع؟ قال: بلى، وكان يقول: سجعُه
يدل على الخلاعة والمجانة، وخطه يدل على الشلل والزّمانة، وصياحه يدل على
أنه قد غُلب بالقمار في الحانة، وما نظرتُ إليه قطّ في وقت إلاّ خِلتُ أنه
قد سَقاه العباره دواء مذ ساعة.
وهو أحمق بالطبع إلاّ أنه طيّب، وإن كان له يومٌ تضاعف حمقه، وذهب طيبه،
وضرَّ أهل النعم والمروّات والأدب بالحسد والكِبر والإعنات.
قلت للخليلي: هل عرفت طالعه؟ قال: حدثني أصحابنا منهم الهروي أن طالعه
الجوزاء كط، والشّعرى اليمانية كط، وكان زحل في الحادي عشر في الحمل كح،
والقمر فيه يط والشمس في السنبلة يج، والزهرة فيها ي، والمشتري في الميزان
كد، والمريخ في العقرب ز، وسَهم السَّعادة في القوس يد، وسهم الغيب في
الجدي يد، والرأس في الثالث في الأسد يا. قال: وخفي عليَّ عطارد. وذكر أنه
ولد سنة ثلاثمائة وست وعشرين من الهجرة، ولأربع عشرة ليلة بقيت من ذي
القعدة روز سروش من ماه شهرير.
قلت فأين وُلد؟ فقال: كان عندنا أنه ولد بطالقان، وقال لنا قوم: بل
بإِصطَخْر. وقال لي غير الخليلي: كان عُطارد في السُنبلة ط ي.
وكنتُ بالري سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة، وابن عبَّاد بها مع مؤيد الدولة
قد وردا في مهمّات وحوائج، وعقد ابنُ عبّاد مجلس جدَل وكنَّا نبيت عنده في
داره بباب سين معنا الضَّرير أبو العباس القاصّ وأبو الحَوراء الرّقي،
وأبو عبد الله النحوي الزَّعفراني، وجماعة من الغرباء فرأى ليلةً في مجلسه
وجهاً غريباً صاحب مرقّعة، فأراد أن يفُرَّه، ويعرف ما عنده، وكان الشاب
من أهل سَمرقند زعم أنه يعرف بأبي واقد الكَراييسي.
فقال له: يا أخ انبسط واستأنس وتكلّم؛ فلك منّا جانب وطِيّ ومشرب رَوِيّ،
ولن تَرى إلا الخير، بم تُعرَف؟ قال: أُعرف بدَقّاق.
قال: تَدُقّ ماذا؟ قال:أَدُقّ الخصم إذا زاغ عن سبيل الحق. فلما سمع هذا
تنكّر وعجب، لأنه فُجئ ببَديعة.
فقال: دَعْ ذا، تكلّم.
قال: أتكلَّم سائلاً؟ والله ما بي حاجةً إلى مسألة، أم أتكلم مسؤولاً؟
فوالله إني لأكسَل عن الجواب، أم أتكلّك مقرِّراً؟ فوالله إني لأكره أن
أُبدد الدّر في غير موضعه، وإني لكَما قال الأول:
لقد عجَمتْني العاجِمات فلم تَجد ... هَلُوعاً ولا لينَ المجَسَّة في
العَجْمِ
وكَاشَفتُ أَقواماً فأَبديتُ وَصْمَهُم ... وما لِلأَعادي في
قَناتيَ من وَصْمِ
فقال له: يا هذا، ما مذهبك؟ قال: مذهبي أن لا أقرّ على الضيم، ولا أنام
على الهون، ولا أُعطي صمتي لمن لم يكن وليَّ نعمتي، ولم يصل عِصمته بعصمتي.
قال: هذا مذهب حسن، ومن هذا الذي يأتي الضَّيم طائعاً، ويركب الهَوْن
سامعاً؛ ولكن ما نِحلتُك التي تنصُرها؟ قال: نِحْلتي طوِيةَ صدري، ولستُ
أتقرَّب بها إلى مخلوق، ولا أُنادي عليها في سُوق، ولا أعرضها على شاكّ،
ولا أُجادل عليها المؤمن.
قال: فما تقول في القرآن؟ قال: وما أقول في كلام ربّ العالمين الذي يعجَز
عنه الخلق إذا أرادوا الاطّلاع على غيبه، وبحثوا عن خافي سرّه، وعجائب
حكمته، فكيف إذا حاولوا مُقابلته بمثله، وليس له مثلٌ مظنون فكيف عن مثل
متيقّن؟ قال ابن عبّاد: صَدقت، ولكن أَ مخلوقٌ هو أم غير مخلوق؟ فقال: إن
كان مخلوقاً كما تزعُم فما ينفعك؟ وإن كان غير مخلوق كما يزعُم خصمك فماذا
يضرّك؟ فقال: يا هذا أَ بهذا العقل تناظر في دين الله وتقوم على عبادة
الله؟ قال: إن كان كلام الله فينبغي إيماني به وعملي بمُحكَمه، وتسليمي
لمُتشابهه، وإن كان كلام غيره، وحاش لله من ذلك ما ضرّني.
فأمسك عنه ابن عبّاد وهو مَغيظ، ثم قال له: أنت لم تخرج من خُراسان بعد.
فمكث الرجل ساعةً ثم نهض. فقال له ابنُ عبّاد: إلى أين يا هذا قد تكسّر
الليل، بتْ هاهنا.
فقال: أنا بعد لم أخرجُ من خُراسان، فكيف أبيتُ بالريّ، وخرج. فارتاب به
ابنُ عبّاد، فقفّاه بصاحبٍ له، ووصّاه بأن يتبع خُطاه ويبلغ مَداه من حيث
لا يفطن له ولا يراه، فما راغ الرجل عن باب رُكن الدَّولة حتى دخل، ووصل
في ذلك الوقت الفائت إليه.
فقيل لابن عبّاد ذلك فطار نومُه من عينه، وقال: أيُّ شيطانٍ هبطَ علينا
وأحصى ما كنّا فيه بيننا، وبلغ أَربَه منّا، وأخذ حاجته من عندنا، بلسانٍ
سليط وطبع مريد.
فحدثني الهَرَوي، وكان يبيتُ عند ركن الدولة: أن ركن الدولة قال
للخراساني: كيف رأيت كاتب ابننا؟ قال: رأيت وجهه وجه خنزير، وعقله عقل
سِنّور، وكلامه كلام مُبَرسم، وحركته حركة مخنّث، ونظره نظر فاجر، ورأيه
رأي مُوسْوَس، وأعضاءع أعضاء مفلوج؛ ولقد عشّانا وتعشّى معنا فما زال يذكر
القِدر والخبز والأدم والبوارد، والغضائر والمطابخ حتى عرقت جباهنا من
الحياء والانخزال، واسترخَت أيدينا من الخجل.
فقال له ركن الدولة: لو علمت أنك هكذا تنقلب عن مجلسه لما أَذِنتُ لك في
لقائه، ولكن قد فات.
قال الهرويّ: وكان هذا الكراييسيّ عيناً لركن الدولة بخُراسان، فلذلك كان
قريباً منه وكان أحد رجالات الدنيا، ولم يتمكّن من مُكاثرته.
وقلت للخليلي: بم انفرج ما بين هذا الرجل، أعني ابن عباد وصاحبكم أعني أبا
الفتح ذا الكفايتين؟ فقال: كان صاحبنا غِرَاً صعب القياد شديد الزَّهو؛
وهذا على رقاعته لتي تَرَى، ولم يكن بينهما عاقل يرأب المصدوع، ويصل
المقطوع، ويرفع الموضوع، ويردّ هذا عن حدّته بلسانه، ويكف ذاك عن تيههِ
وامتنانه. وقد كان ركن الدولة يكنُفهما بظله، ويكُفُّهما بفضله، ويخفض
لهما جناح إحسانه، ويمزج بينهما في استخدامه، ويجمعهما على طاعته لصحّة
رأيه وحسن مداراته؛ ونفوسهما على ذلك تغلي، وصدورهما تفيض، والألسنة
تكَنّي، والحواجب تتغامز، والشِّفاه تلتوي، والأعين تختلج، والوشاة تدبُّ،
والزمان يعمل عمله؛ فلما مضى سائسهما تفارقا القرحة، وتنازعا الرتبة فكان
ما كان.
قلت: ما الذي كان ينقم هذا من ذاك، وذاك من هذا؟ فقال: كان صاحبنا يقول:
أشدّ ما عليّ أن خصمي مُعلِّم مأْبون. وكان هذا يقول: كيف أُسامي حَدَثاً
صغير الرأس، كليل اللسان، قليل الهمّة، الخيرُ عنده حرّ والدِّرهم في نفسه
ربّ؛ وكان يُنشد فيه:
فتىً يمنعُ الطَّعا ... م ولا يمنَع الحُرَمْ
فجميع النساءِ في ال ... حِلّ والمطْبخُ الحَرَمْ
فهذا هذا.
قلت لأبي عُبيد النصراني ببغداد، وكان سهل البلاغة حلو اللفظ، حسن
الاقتضاب، غريب الإشارة، مليح الفصل والوصل: كيف ترى كتابة ابن عباد؟
فقال: هي شوهاء فيها شيء في غاية التنقيح، وفيها شيء في غاية
الركاكة، وبينهما فُتور راكد، بمذاهب المعلمين الحمقى المتعاقلين أشبه
منها بمذاهب السلف الأولين من الكتّاب وأصحاب الدواوين.
قال: السّجع الذي يَلْهَج به هو مما يقع في الكلام، ولكن ينبغي أن يكون
كالطّراز في الثوب، والصَّنفة في الرداء، والخط في العَصب، والملح في
الطّعام، والخال في الوجه؛ ولو كان الوجهُ كله خالاً لكان مقلياً.
قال: وبديعه في هذا الفن لا تُستَر ركاكته في سائر فنون الكلام، فإن فنون
الكلام محصَّلة على التقريب بين البدَد والسجع والوزن، وما يُسمّيه قوم
تجنيساً وتطبيقاً.
قال: ومنها شيء يجب أن يُسمّى المسلسل، وأمثلته في كلام أبي عُثمان
موجودة، ثم قال: والذي ينبغي أن يُهجَر رأساً، ويُرغب عنهجُملة التكلُّف
والإغلاق، واستعمال الغريب والعَويص، وما يستهلك المعنى أو يفسده أو
يُحيله، ويجب أن يكون الغرض الأول في صحّة المعنى، والغرض الثاني في تخيّر
اللفظ، والغرض الثالث في تسهيل النّظم وحلاوة التأليف، واجتلاب الرّونق،
والاقتصاد في المواخاة، واستدامة الحال، ليستمر الثاني على الأول، والثالث
على الثاني، وأن تتوفَّى الفضاء الذي يَعرض بين الفضل والفصل.
قلت: ما معنى الفَضاء؟ قال: عَدَم الرِّباط بين المتقدِّم والمتأخِّر، وهو
النُّبُوُّ العارض في النَّفس عند سماعه وتحصيله.
قال: والهُجنة التي ليس بعدها هُجنة، والركاكة التي ليس فوقها ركاكة،
الوَلوعُ بالغريب، وما يُشكل فيه الإعراب، ويتجاذبه التأويل؛ فإنَّ هذا
وما شاكله كُلفة على النفس عند سماعه، ومؤونة على الطَّبع عند تخيّره،
ومشقّة على اللّسان عند اللّفظ به.
ثم قال: فخَيْر الكلام - على هذا التصفُّح والتحصيل - ما أيّده العقل
بالحقيقة، وساعده اللفظ بالرّقة، وكان له سهولة في السّمع، ووَقْع في
النّفس، وعذوبة في القلب، ورَوْح في الصدر؛ إذا ورد لم يُحجب، وإذا صدر لم
يُنْسَ، وإذا طال لم يُملّ، وإذا قصُر لك يُحقر، له غَنج كغنج العين، ودلّ
كدلِّ الحبيب، ولذّة كلذّة الغِناء، وانقياد كانقياد الذّليل، وتيهٌ كتيه
العزيز، وجَمْشٌ كجمش الغانية، ووقارٌ كوقار الشّيخ، وحلاوة كحلاوة
العافية، ولينٌ كلين الصّيّب، وأخذٌ كأخذ الخمر، وولوجٌ كولوج النسيم،
ووقعٌ كوقع القطر، وريحٌ كريح العِطر، واستواءٌ كاستواء السَّطر، وسبْكٌ
كسبك التِّبر، يجمعُ لك بين الصّحة والبهجة والتّمام.
فأما صحته فمن جهة شهادة العقل بالصواب، وأما بهجته فمن جهة جوْهر اللّفظ،
واعتدال القسمة، وأما تمامه فمن جهة النّظر الذي يستعير من النفس شغفها،
ويستثير من الرُّوح كَلَفها.
وقال: قال أبو الرَّبيع: الكتّاب سبعة: الكامل، والأعزل، والمبهِم،
والرِّقاعيّ، والمُخِيل، والمخلّط، والسّكّيت.
فأما الكامل فهو الذي له في الإنشاء والإملاء حظٌّ. والأعزل: الذي يُمْلي
ولا يكتب. والمبْهم: الذي يكتُب ولا يُملي. والرقاعيّ: الذي يبلغ في
الرِّقاع حاجته، ولا يصلُح لعظم الكتابة؛ والمُخيل: الذي له عارضةٌ وبيان،
ورِواية وإنشاء، وتعرُّفٌ بالآداب، ولا طبعَ له في الكتابة؛ وإذا كان
عاقلاً صلُح لمنادمة الملوك. والمخلّط: الذي يُرى له في الكتاب الواحد
بلاغةٌ جيّدة وفَدامة عجيبة. والسّكّيت: المتخلّف المتبلّد، وربّما جاء
بالشيء المحتمل إذا تَعَنَّى فيه.
قلت فمِن أيهم ابنُ عباد؟ قال: هو مُشكِل، لا يجوز أن تهضمه فتضعه في أسفل
سافلين، ولا يجوز أن تغلظ فيه فترفعه إلى أعلى عِلِّيِّين، ثم ضَعْه بين
هذين أين شئت، على أنه على كلّ حال جبلي.
قلتُ له: قد استمرّ قولك بما لو كان تصنيفاً لك لساغَ، وبقي تمامُه في
كلمة هذا وقتُ المسألة عنها ومعرفة الحال فيها.
قال: قُل، فقد استرسلنا في الحديث، وتباثثنا كلّ ضمير.
قلتُ: كيف ترى كتابنا أعني القرآن؟ وأنت رجلٌ قد أشرفت على غاية هذا
الباب، واستوعبْتَ جميع ما فيه.
قال: ذاك كلامٌ ليس فيه أثرٌ للصَّنعة، ولا علامة للتكلُّف، وهو
كلام منسكب انسكاباً، وجارٍ جرياً يزيد من لُطفه على الطبع، بقدر ما يزيد
الطبع على التصنُّع، قليله كثير، وكثيره غزير، ومعناه أقوَم من لفظه،
ولفظه أرشق من وزنه، ووزنه أعدل من نظمه، ونظمه أحلى من نثره، ومجموعه
أبْهى من مفرّقه، ومُفرّقه أظرف من مجموعه، وبعضه أغرب من كله، وكلّه أعجب
من بعضه؛ وهو شيء يستوي تعجّب الجاهل، وتحيُّر العالم، ويستعلي الذهن
ويستغرق الفهم، ويحجب الرُّؤية عن الإدراك، ويرُدُّها إلى البديهة في
التسليم، وهذا يصحُّ ويبينُ لمن كان ذا أداة تامّة، وعقلٍ ثابت، وعلمٍ
غزير، وطبعٍ سجيح، وبصر بالجوهر صحيح، ومعرفة بالصورة والصُّورة، وتمييز
بين الحال والحال، ورِفقٍ فيما يزيد البيان عنه، لا يحمّله ما لا يُطيق،
ولا يحتمل له ما لا يجب، فيكون في جميع ذلك كالطبيب الحاذق، والنّاصح
المُشفِق.
قلت له: إنما يكون هذا كله وما هو عتيد عندك داعياً إلى الإيمان به،
والتصديق لصاحبه.
فقال: أتُراني لا أنصح لنفسي في قضاء الحق عنها مجْتلباً للسعادة، كما لا
أنصح لها في اقتضاء الحق لها مُكتسِباً للزيادة؟ بلى والله! ولكن وراءَ
هذا ما يُشكل ويُعضِل، ويَطول ويُمِلّ.
وكان هذا الرجل ممن يدون كلامه كما يدون كلام ابن هلال الصّابي.........
صاحباً له: يا هذا! انفع صاحبك على كل حال وإن ضرّك، وزيّنه زإن عَرَّك،
وحسِّن به ظنّك وإن غرّك.
ومما يدلّ على ولوع ابن عبّاد بالسجع ومجاوزة الحدّ فيه بالإفراط قوله
يوماً: حدّثني أبو علي ابن باش، وكان من سادة النّاش، جعل السين شِيناَ
ومرَّ في الحديث وقال: هذه لُغة. وكذب وكان كَذوباً.
وكان أبو مالك يكتب بين يديه فقال له: إنما أنت خطّ وقطّ فقط. وفتَّت
أطرافه بحركاته تخنّثاً وتأنّثاً.
وقال لعبد الله المعلم، وقد أنشده: يا عبد الله! أنت طويل النفس، عتيق
القَوْس، شديد المَرس.
وقال الشيخ من خراسان في شيء جَرَى: والله لولا شيء لقطعتك تقطيعاً،
وبضَّعتك تبضيعاً، ووزّعتك توزيعاً، ومزّعتك تمزيعاً، وجرّعتك تجريعاً،
وأدخلتك في حر أمّك، ثم توقف وقفةً وقال: جميعاً.
ومِلح هذه الحكاية ينتثر في الكتابة، وبهاؤها ينتقص بالرواية دون مشاهدة
الحال وسماع اللفظ، وملاحة الشكل في التحرك والتثني، والترنّح
والتهادي،ومدّ اليد، وليّ العنق، وهزّ الرأس والأكتاف، واستعمال الأعضاء
والمفاصل.
وقلت لابن القصار الفقيه: لو ناظرته، وكان يذهب مذهب القلانسي. فقال:
الرجل كلف بالمذهب لا يُفهمك ما يقول استكباراً عليك، ولا يَفهم ما تقول
استحقاراً لك.
وطلع عليّ يوماً في داره وأنا قاعد في كسر رواق أكتب له شيئاً قد كادني
به، فلما أبصرته قمت قائماً، صاح بحلق مشقوق: اقعد! فالورَّاقون أخسّ من
أن يقوموا لنا، فهممت بكلامٍ، فقال لي الزعفراني الشاعر: احتمل فإن الرجل
رقيع، فغلب علي الضّحك، واستحال الغيظ تعجُّباً من خفّته وسخفه، لأنه قال
هذا وقد لَوى شِدقه وشَمَخ أنفه وأمال عنقه واعترض في انتصابه وانتصب في
اعتراضه، وخرج في مَسْك مجنون قد أفلت من دير حَنون. والوصف لا يأتي على
كُنه هذه الحال لأن حقائقها لا تدرك إلا باللّحظ، ولا يؤتى عليها باللفظ.
أَ فهذا كلُّه من شمائل الرّؤساء وكلام الكُبراء وسِيرة أهل العقل
والرّزانة؟ لا، والله! وتُرباً لمن يقول غير هذا.
وسمعت الخثعمي الكاتب كاتب علي بن كامة يقول: ما رأيت في طول عمري مع
عُلوّ سِنّي وكثرة تجارتي تتبُّعي رجلاً أجمع للمخازي والمقابح والرقاعات
والجهالات والخساسات والفواحش والخبائث من ابن عبّاد؛ أَفْيَلُ الناس
رأياً إذا ارتأَى، وأنكلهم عن الخصم إذا تراءى، وأقلّهم وفاءً لمن جعله
الله وليّ نعمته، وأوقحهم وجهاً مع كلّ إنسان، ولأحدهم لساناً بكل خنىً
وفحش، وأحسدهم لنظيرٍ ولمن دون النَّظير، وأسعاهم بالفساد على الصغير
والكبير، وأخطبهم على الدّين، وأضرّهم للمسلمين، وأفجرهم من بين العالمين،
فقلت له: ما الذي يمدُّه على ما هو فيه، وبأي شيءٍ يطرد له ما هو عليه؟
فقال: لم يبق فيمن فوقه من ينتقد، ولا فيمن دونه من يُزاحم؛ قد
خلا له الجوّ فهو يبيض ويصفر، ويتمطّى ويبوع، ويقول سبعاً في ثمان؛ لم
يذلَّ لأحدٍ وذلَّ له كل مُحتاج، وأمر كل إنسان وما نهاه إنسان، وضَرع
إليه كل محتاج، وما احتاج إلى غيره، ونشأَ على البطر والجنون، وعلى
الخلاعة والمجون؛ فبهذا وأشباهه فسدت أخلاقه، وساء أدبه، وبذُؤ لسانه،
ووقح وجهه، وغلط في نفسه غلطاً شديداً؛ وأُعجب بعربيته إعجاباً بعيداً؛
وهكذا يفسد كل من فقد المخطِّئ له إذا أخطأَ، والموبّخ له إذا أساء،
والمقوّم له إذا اعوجّ؛ لا يسمع إلاّ: صدَقَ سيدنا، وأصاب مولانا؛ وماله
في الزّمان ثانٍ، ولم يُعْرَف فيمن تقدّم له نظير.
رجل في هذه المملكة الواسعة العريضة على ما ترى من التمكن والاستعلاء، وهو
لا يُحصّل شيئاً من خرابها وعمارتها، ولا ينظر في مصلحتها ومفسدتها، ولا
يعرف المُختلس منها ولا الضّائع بين الناظرين فيها. أعمال بائرة، وبلادٌ
غامرة، وأموال محتجنة، وطمع مستحكم، وضعف غالب وعدوٌّ راصد، ووقت فائت
بالفُرَص، وخوف مؤذن بسُوء العاقبة؛ وهو قاعد في صدر مجلسه يقول: قال
شيخنا أبو علي وأبو هاشم، تارةً يتقلّس ويتعمّم ويتلحّى ويناظر العامّة؛
هذا البقّال وهذا الخبّاز وهذا الخُلقانيّ وهذا الإسكافَ بالفارسيّة إما
بالدَّرية، وإما بالرّزاية وإما بغيرهما؛ ويرى أنه في شيء مهم، وأنه في
نشر مذهب ونُصرة دين؛ وتارة يناغي هذا الأمرد، ويعاتب هذا الخادم، وينشد
الشعر البارد الذي يُورث الفالج:
أبا يوسفٍ إن العثانين آفة ... على حامِليها فاتخذ لحيةً قصْدا
ولا تَكُ مشغوفاً بسَحْب فضولَها ... ولا تُوِلَها إلا الإبادةَ والحصْدَا
وينشد:
قد استوجَب في الحكم سُليمان بن مختار
بما طوَّل من لحي ... ته التحريق بالنارِ
أو النتفَ أو الجزَّ ... أو النشرَ بمنشارِ
فقَد صارَ بها أَشه ... رَ من رايةِ بيْطَارِ
فإذا أَمَلَّ الشعر قال: قال سعيد بن حُميد لأبي هفّان: إن ضرطتُ عليك
لأُبلّغنك إلى فَيْد. فقال أبو هفّان: زدني أخرى تُبلّغني مكة، فإني
صرُورة.
أَ تدري يا أبا فلان ما الصَّرورة، وكم لغة فيها، وما أصلُها، وما
نظيرتها؟ ويقول: ضرب المتوكّل على قفحة عُبادة فضرط، فقال: ويحك ما هذا؟
فقال: يا أمير المؤمنين، خليفة يقرع باب قومٍ فلا يجيبونه؟ ويقول: مَرَّ
بعليّ بن الحسين العلويّ رجل عبّاسيّ مأبون، فقال: من هذا؟ فقيل: هذا تيس
الجِنّ.
فقال: ينبغي أن يُقال له نَعجة الإنس.
ويقول: جمع مُزَبّد بين قَبحةٍ وصديقها في بيت فتعاتبا، فأراد أن يجامعها
فامتنعت وقالت: ليس هذا موضع ذا، فسمعها مُزَبّد فقال: يا زانية فأين
موضعه أبين القبْر والمِنبر والله ما بُني هذا البيت إلا من جذْرِ
القِحاب، ولا وُزِن ثمن خشبه إلا من أثمان نِعالٍ اختُطِفت في شهر رمضان
من المساجد، وما اشتريت أرضه إلا من السّرقة، وما أعرف موضعاً أحقّ
بالزّنا فيه منه.
وكان ينشد لابن الحجّاج كلّ سُخف ويستجيده ويُعجب به؛ أنشد له يوماً:
يسائلني محمّد عن أَخيهِ ... وعنهُ وقد بَلوتُهما شديدا
فقلتُ كلاكما جِعسٌ ولكن ... أَخوك، الحقَّ، أَكثَرُ منكَ دُودا
ويقول: امرؤ القيس والنّابغة يقصّران عن هذا الفن.
وينشد أيضاً له:
ومصرّفٍ أَنفاسَ ليثٍ خادِرٍ ... يصْدُرن عن لهواتِ كلبٍ رابضِ
ذي لثّةٍ غرويةِ الريا وذِي ... لحمٍ مُصِلٍّ في لعابٍ حامِضِ
رثِّ الثيات يحز منبته دما ... فكأَنما شَفتاه شفْرَا حائضِ
لم أَدرِ ماذَا قالَ إلا أَنه ... ما زَال يفسو ضِرسُه في عَارضتي
ومن أحاديثه السَّخيفة التي يتنّزه عنها الرؤساء، قال: قدِم أبو فِرعون
الأعرابي وكان يسمّى سلمان البصرة، فنظر إلى بعض آل المهلّب على بابه قد
فرش له، ووصيفة أدماء كأنها طبية قائمة تذبُّ عنه، فجعل يجمح إليها ويحدّ
النظر، فقال له صاحبها أتشتهيها؟ قال: إي والذي خلَقها.
قال: فهل لك أن تكشف عما معك بين يديّ وتنكحها وتنكحها وأنا أنظر؛ فإن
فعلت ذلك فهي لك.
فلما ألقاها وأخرج متاعَه كأنه عمود البيت، وبرّك عليها صاح به
الناس: زَرّ، زَرّ، فأكثروا عليه، فاستحيا وفتر وولّى هارباً والناس في
إثره يصيحون، وأخذ برأس متاعه وقال:
يالك من ايرٍ جُزيتَ شرّا
أَقمتُه حتى إذا اكفَهرّا
واضطَرَبت أَعراقُه ودَرّا
عادَ إليَّ وجهُه مُزْوَرّا
أُرِيد جُوَّا ويريد بَرَّا
كأَنَّه صاحبُ ذنبٍ فرَّا
كأَنما أَلقِم شيئاً مُرّا
وما عليك أَن يُقالَ زرَّا؟
وحدّث أيضاً: قال عُبادة: اختصم الحر والحجر في الجلدة التي بينهما، فكان
كل يدّعيها، فتقدّما إلى الاير. فقال ليست لأحدكما.
قالا: فلمن هي؟ قال: هي لي إذا دخلتُ حططتُ عليها رحلي، وإذا خرجت استرحت
عندها من كَربي.
وحَكى يوماً عن جحظة قال: كانت لي جارية فحبلت، فقلت لها: يا ملعونة مَن
أحبلك! قالت: مَن غرَّقه يا مولاي.
قال: وقيل لعُبادة: لم صار الصَّفع بالقرع على القفا ثقيلاً، وفي الجوف
خفيفاً، قال: لأنه ينزل على القفا جملة ويدخُل في الجوف تفاريق.
وكان ديدَنُه السُّخف والخلاعة والمُجون، والرواية عن مُزبّد المدني وأبي
الحرث حمين وعُبادة، وجحظة ونَضْلة بن البك ومَن أشبه هؤلاء. وكان يضع
أحاديث من الفواحش على بني ثوابة ويرويها عنهم ويَسمُهم بها. وكان القوم
مُعاذِين منها، على ما حدّثنا شيوخ جِلّة كرماء لهم دين ومروّة. وكان
يتكذّب على اليزيديين وغيرهم. وكان أكثر هذا فيه، وإنما كان يتحدّث بمثله
تَبَرُّؤاً ونزاهة، وكان أدنسَ من الخنزير.
ولمثل هذه الخصال كتب إليه أبو راغب، فتىً من آل أبي جعفر العُتبي الوزير
بخراسان رسالةً هتكه بها؛ وأنا أرويها لتعلم أني لم أتفرّد بتهجينه
والنكير عليه، بل كلّ حُرّ كريم، وكل ديّن مذكور، وكل ذي مروّة ظاهرة معي
فيما نثوتُ عنه وكرهته منه؛ فإن لم تعبأ بما تسمع مني فاعبأ بمن لعلّه
عندك أشف مني، ولا تتسرع إلى عيبي هذا الرجل بما قد دوّنته حتى تتبيّن
الأمر على حقّه وصدقه.
كتب أبو راغب: أصلحك الله أيها الرجل لنفسك، فإنك إذا صلحت لنفسك صلحت
لقريبك وبعيدك.
أما بعد فإن بُعد صِيتك بعثَني على تصفُّح شأنك، وتصفُّحي لذلك وقفني على
أحوال كرهتها لك، وأنفتُ منها لمن بلغ دَرجتك، والعيب منك مُضاعف،
واللّسان فيك جوّال، والحقد عليك سريع؛ ولولا الحال التي أنت عليها من
القُدرة والتمكُّن لكان العذر يناضل عنك، والتوبيخ يتبدّد دونك، وما أحسن
ما قال شاعر عصْرك في نظمه:
ولك أَرَ في عيوبِ الناسِ شيئاً ... كنقص القادرين عَلَى اللتمامِ
قد خولّك الله ما يفوت ذرع همّتك، وآتاك ما يتجاوز اشتطاطك في حُكمك، من
المال والثروة والرياسة والعلم والقوة والمكانة؛ ولم يخصّك بهذا كله
بسابقةٍ لك عنده، ولا حقّ لك عليه، بل كلّه تفضُّل في الأول، واختبار في
الثاني، وثواب أو عقاب في الثالث.
ولقد شاهدت وسطي في تعرُّف أخبارك، واستعنت كلّ عينٍ وأُذن في معرفة ليلك
ونهارك، فلم أجد في تفصيل ذلك إلا ما يعصب برأسك العار، ويحشد عليك أسباب
الدّمار، وتكون عاقبتُك منه دخول النار؛ لأنك تظهر القول بالوعيد ثم تركب
كلّ بعير كبير، من أخذ المال المحرَّم، واستباحة الحريم المصون، وقتل
النّفس المؤمنة، ومُساهمة الفسَقة الفجرة، وخِدمة الظلمة الغَشمة، وتقديم
أهل المُجون والعيارة، وفي عُشر هذا سقوط المروّة، والإنسلاخ من الديانة.
فيا أيها المُدِلُّ بالتّوحيد والعدل أَ هذا كله في مذهبك أو في مذاهب
أسلافك؟ مثل واصِل بن عطاء وعَمرو بن عُبيد، وأبي موسى المُرْدار،
والجعفَرين؟ أما كانوا - مع بِدعتهم التي شانوا بها وجه الإسلام، وكادوا
بها أهله - مجتهدين في غير ما أنت به راضٍ لنفسك ومُصرٌّ عليه باغترارك؟
إن الله لا يخادع، ولا منجاة للعبد إلا بالطاعة الخالصة، والتوبة النّصوح؛
هذا إذا كان الإيمان ساكن صدره والخوف من الله متردداً في أقطار فكره،
واليقين بالمعاد عمود دينه، والعلم بالجزاء راسخاً في فؤاده؛ فأمّا إذا
كان عارياً من هذا كله فهو الكافر بعينه الذي سمعت به، وعاقبة الكافرين
(جَهنَّمَّ يَصْلَوْنَها وبِئسَ الْمَصِيرُ).
والله ما حركتني لنبذ هذا الكلام إليك حِيبةٌ عليك؛ لأني لم
أنتجِعك، ولم أطمع في مالك، ولا عرفت وجهي، ولا سمعت باسمي، لكن أبت نفسي
أن تقرّ على الجهل بحالك، وبِدُخلة ما يكون أمثالك، فآثرتُ نصيحتك؛ فإن
النّبي صلى الله عليه قال: " الدِّين النَّصِيحة " . وما أخوفني أن تكون
جرأتك على هَتك حُرُمات الدين، ومُعارضة الصالحين، مع العكوفة على
الخُسران المبين، إنما قَويت ورَبت لأنك شارد على ربك، نافر من دين نبيّك،
مُدَّع له بلسانك، شاكٌّ فيه بفؤادك، مُتعجّب ممّن له إخلاص، أو له
بالدَّينونة اختصاص؛والويل لك إن كنت بهذا قانعاً من نفسك في الحال
الأُولى، ثم الويل لك مع الثُّبور إن كنت جاهلاً بما عليك في الحال الأخرى.
حدّثني أي أمرٍ أنت فيه على رشد، وآخذ منه باحتياط؟ أما أنت عليه مع
الغلمان المُرْد الجُرد؟ أم ما أنت مشهور به من المجانة والسُخف؟ ثم تدّعي
الإطعام للخاصّ والعام، وقد شاهدنا فوجدنا على بابك قوماً يضربون بالمقارع
وجوه الناس، ويُحطُّون على رؤوسهم العذاب، طرداً لهم وإبعاداً، أَ فَما
هذا بأمرك وعينك وأُذنك؟ فلِم تتكلّف ما لا تُقرّ به؟ ولِمَ تدّعي مالا
تسلم فيه؟ لقد وقفنا عياناً من استخفافك بالأحرار، ووضعك من ذوي الأقدار،
وكُفرك بوليّ نعمتك، وتعرّيك من كل شبهة في أمرك، ما لو تنفَّسنا به بين
الناس، أو رسمناه بالقلم بالقرطاس، لكان ذلك زائداً على تمرّد فرعون، وكفر
أبي جهل وجُرأة ديك الجن.
لقد قيسَتْ مروّتك إلى مروات قوم قُرفوا بالزندقة فوُجدت مروّاتهم فوق
ديانتك، ولقد رأينا قوماً لم يتحلّوا بالدعوى تحلّيك استنفدوا قوتهم في
طلب مرضاة مؤمِّليهم ومُنتجعي قطْرهم، وبلغوا من ذلك المبالغ. وأنت مع
تمكّنك ويسارك لم تسمح من الشاة بظلفها، ثم ملأت الدنيا بَقْباقاً
بالامتنان على الصغير والكبير، كأنك خالق الخلق وباسط الرزق. انظر أيها
الرجل أي آخر سوءٍ لك؛ والله إنك شديد الثقة، وقد قيل: رب واثق خَجِل.
أيها الرجل!
ما طار طَير فارتَفَعْ ... إلاّ كما طار وقَعْ
أما تعتبر بما آل إليه أمر ذي الكفايتين مع ذلك البأو والخُنزُرانة؟ أما
رأيت بعينك في هذه السنين ما يحدوك على الأخذ بالوثيقة لنفسك؟ وكف اليد عن
كثير مما يوتغ دينك، ويهشم أنف مُروتك، ويقطع عرق أُبوتك، ويهيج الألسنة
على تبكيتك، ويبسط الأيدي في الدعاء عليك، ويحشو القلوب في الدعاء عليك،
ويحشو القلوب تمنِّي زوال دولتك.
فاتَّعظ بقول الشاعر:
يا أيها الباغِي عَلَى الأَحرار ... ثقةً بلِين مَقادَة الأَقدارِ
لا تَغْتَررْ بمدىً تَطاولَ حينُه ... فالظلْمُ يُقصِر من خُطى الأَعمارِ
والعيشُ نَهْلةُ واردٍ ولَرُبَّما ... سُدَّت عليه مَدارجُ الإِصدارِ
وأختم قولي هذا بما قال بعض السّلف لأصحابه، قال: أُحذِّركم الدُّنيا
وأُخوّفكم يوم التَّناد، يوم لا يُعرف لخيرٍ أَمَدٌ، ولا ينقطع لشرٍّ أمد،
ولا يعتصم من الله أحد.
وأرجو أن تسمع ما صدقت القول فيه بانتصاح، وتعرف ما تؤتيه بارتياح،
والسلام.
قال: ويقول أيضاً: قال أبو العيناء لحجّاج الكاتب: ابنك في أي شيء هو من
النّحو؟ قال: هو في باب الفاعل والمفعول. قال: هو إذن في باب والدَيه.
ويقول: قيل لأعرابي: اشترى الأمير سراويل من فَنَك. قال: التقى الثوبان.
ويُنشد:
شيخٌ لنا يُعرَفُ بالخُلْدِي ... يُريده في غلظ المُردِي
أَدْخَلنِي يوماً إلى دارِه ... فناكَني والايرُ من عندي
قال الخثعمي: وهو في هذا اكله على نَزَق فيه شديد، وقهقهة عالية، وتفكُّك
قبيح، وسيَلان مُنكر، وشمائل مندثرة.
الويلُ له! هلاّ ترك هذه السخافات والحماقات على قومٍ يليق بهم هذا
النّمط، وأقبل على الدّولة فنظم مختلّها، وسدّد التي ليس لها محصول.
يا قوم! أيُّ دينٍ يصحّ له وقد قتل آل العميد؟ وأي وفاءٍ يسلم له وقد سمّ
أولاد بُويه الذي هو وليّ نعمته، وحافظ مُهجته، وباسط يديه، وبه نال ما
نال، وبلغ ما بلغ؟ وأيّ مُروّة تبقى له، وهو يمنّ بالقليل إذا أعطى؟ وأي
كرم يُعتقد فيه، وهو يَغُرّ الآمل ويسحبه على الوعد حتى إذا انتهى فقراً
أو ضجراً حرمه حرماناً يابساً، ورده ردّاً مُرّاً، وأعطاه شيئاً قليلاً
وقحاً؟
وهل تجد فيمن تقدّم عنده ونفق عليه غير ابن المنجّم وهو يعبث
بلحيته وهامته؛ ويسخر منه ويضحك به؛ ويعمل له الشعر في النّوروز والمهرجان
وغيرهما، ويسمعه في هيئة يوم المحفل، ويطرب على إنشاده ويقول: ما أحسن
شعرك! وما أسلسَ طبعك! ويُطيعه على ذاك، ويتقدّم إليه بالقيادة وبكل ما لا
يُجيزه الدين والمروة؛ وكذلك ابنُ نجم الآخر أبو محمد جِبسٌ جاهل
صلِف،وسبيله وحديثه أو يقول: وردتُ على مولانا الصاحب، وأنا كالبدر إذا
طلع، فعشِقني وعشق عِذاري وهام بسببي ورُزِقتُ منه، وخففت على قلبه،
وحظِيت عنده، وكان يُعجبه منّي ما لا يجوز التحدّث به.
وصدق الخثعمي في هذا كله؛ كان أبو محمد يقول ما هو أكبر مما قال، وكان مع
ذلك في مَسك كلبٍ خِسّةً ولؤماً وطمعاً؛ رأيته يوماً وقد كتب لإنسانٍ
كتاباً بمكنسةٍ أخذها منه وجعلها في كُمّه.
وقضى لآخر حاجةً بعشر باذنجانات، والباذنجان إذ ذاك بالريّ مائة بدانق.
وقال أيضاً الخثعمي: وهل يتقدّم عنده إلا هؤلاء الهُوج الطَّغام الذين
يجوبون الدنيا، ويدخلون كل ميدان، ويسخرون منه فيقولون: فعَل مولانا، وكان
مولانا، وما رأينا مثل مولانا؛ وإن رأى مولانا أمكننا من نسْخ رسائله
وكَتْبِ ألفاظه، فإذا سمع هذا وأشباهه ماعَ وسال وترَجْرَج وذابَ وأعطى
عليه وجاد.
وقال أيضاً: كيف يُدَّعى له التَّبريز في كل علم وهو لا يعرف النحو إلاّ
ما جلّ منه، ومن الكلام إلا ما وضح؛ ثم هو في اللّغة على تصحيفٍ شديد،
وتخليط كثير، وفي الأخبار على تمويهٍ لا يخفى على مُميّز؛ وقد أفسد رسائله
بطريقة المتكلّمين، وأفسد طريقة المتكلّمين بطريقة الكُتّاب، وكذلك النّحو
واللغة والحديث، وهذا وصفٌ لا يدفعه إلا مُكابر.
وصدقَ هذا الشيخ، فإني رأيت ابن ثابت البغدادي المحدّث، وقد سأله عشيةَ
يومٍ عن قول النبي صلّى الله عليه: " قَوِّموا صُفُوفَكم فَتراصُّوا، لاَ
تَتخلَّلكم الشياطين كأنّها بَناتُ الحذَف " : ما الحذف؟ فلم يُجبه وقال:
سأقول لك، وأخذَ في حديث آخر.
قال الخثعمي: وهو مع هذا كلّه يكذب صُراحاً في كل شيء، يقول: كان عندنا
معلّم، وسُئل عن " يوسف " أَ ذكر هو أم أُنثى؟ فقال: " يُوسف " يُذكَّر
ويؤنَّث، ألا ترى إلى قول الله عزّ وجلّ: (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا)،
ثم قال: (وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ)، وقد اجتمعت له العلامتان.
واكن هذا ينسبه إلى إنسان معروف بالأدب، ولكنه كان يُحمّق ابن عبّاد وينُث
مخازيه، فكان هذا يضعُ عليه نوادر باردة.
قال: ويقول: دخلت بغداد فلقيت أبا سعيد السِّيرافي، وعليّ بن عيسى،
والمَراغيّ؛ وناظرتُ المراغيّ في " عَسَى " و " لعلّ " و " كاد " وغير ذلك
فأبرزتُ وذُكرت، وأشير إليّ بالأصابع، وفسح لي في المجامع؛ وكذلك ناظرتُ
فلاناً وفلاناً، وأفدتهم أكثر مّما استفدتُ منهم.
وسألت أنا أبا سعيدٍ عن هذا فقال:سُبحان الله! وسكت استعظاماً لهذا الحديث
ونفياً له. وهو كما أومأ إليه.
وقلتُ للمراغي: أ كان لهذا الحديث أصلٌ فقال: لا، والله.
وقال الخثعمي: وهل يدلّ ولوعه بالعَروض إلا على سوء الطبع وقلّة التأتّي؟
وكان أخذها عن البديهي، وإنما ردؤ شعر البديهيّ أيضاً لمثل هذا، وبلغ من
جنونه عليها أعني العَروض أنه كان يُلقيها على كل إنسان، ويطالب به كلّ
شاعر وكاتب، حتى أخذ في هذه الأيام يلقّن غُلاماً تركياً وآخر قُوهياً
وآخر زنجياً؛ وكان يُظهر بهذا وما أشبهه الحذقَ والبراعة والتخريج.
ثم ينظر في كتاب " الفصيح " ، " ومختصر " الجَرْمي، ويقول: ما رأيتُ
كاتباً يُخطئ إلا من هذا، ولا يَلحَن إلا من هذا. وهذا - حفظك الله - منه
مُغالط، إن الكاتب قد يُخطئ من غيرهما أيضاً، وهو ذاك المُخطئ المحرِّف
إذا وزنتَ كلامه بالقسطاس، واعتبرته بالقياس على ما أوضحه العلماء
والنحويون، قال: ومَن أرادَ ذلك بيّنتُ له، فليس الباب دونه مُغلقاً ولا
الطريق إليه مُتعسَّفاً.
ثم قال الخثعمي: وهل مَداره إلا على السُّخف والجَبَه والمكابرة والبَهت،
يقول فيمن هو أكتب منه وأعَفُّ وأَسرَى:
حجر أَبي نَصْرِ بن كوشاد ... أَوسعُ من مصرَ وبَغدادِ
قلتُ له: هل لك في فَيشَةٍ ... فقال مولايَ وأُسْتاذِي
أَ فهذه مخايل ذوي الأقدار والرياسة؟ أم مخايل أصحاب الرَّعاع والسفلة؟
وهل شاع القول بتكافؤ الأدلة في هذه الناحية إلا به؟ وكثرا
المِراءُ والدل والشّكّ إلا في أيامه، لأنه منع أهل القصص من القصص والذكر
والزّجر والمواعظ والرقائق، ومنع من رواية الحديث - وقال: " الحديث " حشو
- وتفسير القرآن، ونشر التأويل، وسماع قول الصحابة والتّابعين، وما يُعنَى
بين الحلال والحرام، ويتعلّق بجلائل الأحكام، وطَرَدَهم ونَفاهم؛ منهم:
ابن فارس، والرُّويانيّ، وابن بابَوَيه، وابن العطّار، وابن شاذان،
والبَلخيّ، وفلان وفلان؛ وأجلس النجّار يخدع الديلم بالزّيدية، وزعم أنه
على مقالة زيد بن عليّ ورأيه ودينه ومذهبه، وزيدٌ يعلم الله - بريءٌ منه،
لفسقه وفجوره وتهتُّكه وظُلمه وغَصْبه ونهْبه وقتْله النفس المحّرمة،
وأخذه الأموال المحظورة. أتُرانا لا نعرف مذهبَ زيد، وأن جميع ما هو فيه
مخالف للدين والإسلام.
وقال الخثعمي: زعم أنه إنما منَع المذكّرين والقُصّاص لئلا يفشو الحشو
والتشبيه ولِئلا يُنشِّئوا عليه الصغير والكبير، فهلاّ منع من الكلام
والجدل لئلا يفشو الإلحاد، ولا تكثر الشُّبه؟ ثم يجلس لأصحاب الحديث،
ويروي ويُفسل ويكذب ويختلق الإسناد ويبتِك المتن. فأي عيبٍ لم يظهر به ولم
يغلب عليه؟ وأيّ خِزْيٍ لم يبن ولم يكثر؟ وأي فعلٍ سيءٍ لا فعله؟ أَ ليس
هو سبب كل قبيحة، وفاتح كل باب شرّ؟ فما هذا الغلط فيه؟ وما هذا التعصّب
له؟ وما هذا اللّجاجُ بسببه؟ أَ من العدل الذي يُدل به في مذهبه أن يجور
ويغصب، ويقتل؟ أم من التديُّن ب " التوحيد " أن يركب الفاحش ويأتي
القاذورات؟ ويخلو بالأُبَن والسوءات؟ ويتسنّم الكبائر المبيرات؟ ثم يبني
داراً يسمّيها دار التوبة استهزاءً وسخرية وسُخْنَةَ عين؟ أم من المعروف
أن يتعاطى كل منكرٍ قولاً وفعلاً؟ إني لأظن أن من ينصر هذا الرجل لأَعمى
أصمّ قد أسلمه الله من يده، وألجأه إلى الشيطان قرينه.
أم من العقل والمروّة والكرم والفتوة أن يقول: أين مائدتنا من مائدة
مطرّف؟ يعني أبا نصر مطرف بن أحمد وزير مرداويج الجبلي، وكان أكرم الناس؛
ومن مائدة المهلبي؟ ومن مائدة ابن العميد؟ وأين طعامنا من طعامه؟ وأين
إطعامنا من إطعامه؟ وكان أبو الفضل سيّداً، ولكن لم يشُقُّ غبارنا، ولا
أَدرك شِوارنا، ولا مسح عذارنا، ولا عرف عَرارنا لا في علم الدين، ولا
فيما يرجع إلى منافع المسلمين. فأما ابنه فقد عرفتم قدره في هذا وفي غيره؛
طيَّاش قلاّش، ليس عنده إلا قاش وقماش، مثل ابن عياش والهروي والحواش.
يا قوم! هذا كلام من له عقل ويرجع إلى رزانة؟ ثم يقول في مجلسه: أنا
الذُّعاف لمن حساني، والجُراف لمن عصاني، والجُحاف لمن عَناني أو حرّك
عِناني؛ أَخْمصي فوق هامة الدّهر، أين ابنُ الزيّات منّا؟ أين ابن خاقان
من غُلامنا، يعني أبا العياس الضّبي، ومن عليُّ بن عيسى الحشوي، ومن ابن
الفرات الأرعن، ومن ابن مُقلة الخطّاط، ومن الحسن بن وهب الضرّاط؟ هل
كانوا إلاّ دوننا إذا ذُكرت سيادتنا، وشوهدت سعادتنا. وُلدت والشِّعرى في
طالعي، ولولا دقيقة لأدركتُ النبوّة، وقد أدركت النبوّة إذ قُمت بالذّبّ
عنها والنُّصرة لها؛ فمن ذا يجارينا ويُمارينا ويبارينا ويُهادينا
ويُضارينا ويُسارينا ويُشارينا؟ وكاد الخثعمي لا يقطع هذا المجلس لطول ما
مرّ فيه، وشِدّة ما أهمّه منه.
فهذا كما ترى.
وقلتُ للمسيبي يوماً: لم انقطعت عن هذا الرجل، وقد كان مُحسناً إليك،
مُقدِّماً لك، مُعجباً بك؟ فقال: الصَّبر على الرَّقاعة مُعوز، ومُكاذبة
النّفس وخِداع العقل من الكلَف الشاقة والأمور الصّعبة، ولَعَن الله
الرّغيف إذا لم يصب إلا بضَعَة النّفس، وغضاضة القدر، وكدّ الروح، ومفارقة
الأدب الحسن، ودَنس العِرض النَّقي، وتمزيق الدّين المعتَقَد، وكسب الزّور
المُحبِط، وإزالة المروّة المخدومة؛ وإني لَكما قال الشاعر:
وإِني عَلَى عُدْمي لَصاحِبُ هِمّةٍ ... لها مذهَبٌ بين المَجَرَّة
والنَّسْرِ
وإِنَّ امرءاً دُنْياهُ اَكبَر هَمِّهِ ... لَمسْتمسِكٌ منها بحَبْل غُرورِ
وسمعته يقول لابن ثابت: جعلك الله ممّن إذا خَرئ شطَّر، وإذا بالَ قطّر،
وإذا فَسَا غَبَّر، وإذا ضَرط كبَّر، وإذا عَفَج عَبّر.
وهذا سُخف لا يليق بأصحاب الفُرضة، والذين نشؤوا بالمزرفة،
واختلفوا إلى الخندق ودار بانُوكَه والزبد والخُلْد.
وسمعته يقول: أنشدني صِقلاب، وابنُ باب، وقرأتُ على ابن البوّاب، وسمعت من
ابن الحُباب، ورويتُ لأبي المرتاب الدّباب كلّ شيءٍ عُجاب.
ولقد تحيّر المهلّبي منّي، وعرف مُعِزّ الدولة فضْلي وأدبي وأكبر قدري،
وبلغ الحدّ الأقصى في أمري.
وأنشدني أو دُلَف الخَزْرَجيّ عندما رأى من كلَفه بالمذهب وإفراطه في
التعصُّب:
يا بن عَبّادِ بنِ عَبّا ... سِ بنِ عبْد الله خُذْها
تُنكِر الجَبْرَ وقَد أُخْ ... رِجْتَ لِلْعَالَم كُرْها
وكان إذا نشط واهتزّ لا يُسمع منه إلا حديث عُبادة وجَحْشَويه وأمثال
هؤلاء.
وكان يضع على بني ثوابة كلَّ حِكاية غَثَّةٍ فاحشةٍ؛ وكان إذا أراد أن
ينفي عن نفسه ما يُقرف به، قال: قيل لقاضي الفتيان: نيك الرّجال ريبة.
فقال: هذا من أراجيف الزُّناة.
وقيل لابن ماسَوَيْه: الباقلَّى مقشورةً أصحُّ في الجوف.
فقال: هذا من طِبّ الجِياع.
وقيل للُوطي: إن اللّواط إذا استحكم صار حُلاقاً قال: هذا من توليد أصحاب
القِحاب.
فأما الذي يدلّ على كلام المُبرسَمين والمجانين ومن قد شُهر بالصَّرع
والماليخوُليا فما سمعته يقول لشيخٍ خُراساني قد دَعَا به وأكرمَه وتوفّر
له وكلَّمه؛ فسمعته يقول: ما يجب أن يكون لا يقتضي، وما يكون منه لا يجب
أن يكون، وقد يجب أن يكون ما يكون، ويكون ما يجب أن لا يكون، وإنما لا
يكون ما يجب أن يكون، ويكون ما يجب أن لا يكون؛ لأن ما لا يجب أن يكون ليس
في وزن ما يكون، والكون والوجوب لا يتلازمان، بل يجتمعان ثم يفترقان،
والاجتماع والافتراق عليهما جاريان؛ فلهذا يُرى الواجب كائناً والكائن
واجباً، وما أكثر من يظنّ أن الكون متضمّن الوجوب، والوُجوب متضمّن الكون،
وتحصيل الفَضْل بينهما بالنّظر من سِحر العقل.
وهذا فنٌ لم أجد فيه لمشايخنا شوطاً محموداً، ولعلي أُملي فيه كلاماً
بسيطاً بجميع ما يكون شرحاً له إن شاء الله.
فلما خرجنا قلتُ للشيخ الخراساني، وقد أخذنا في المؤانسة وتجاذينا أطراف
الحديث كما قال الشاعر:
أَخذْنا بأَطرافِ الأَحادِيث بينَنَا ... وسَالَتْ بأَعْناقِ الْمَطِيِّ
الأَباطحُ
كيف سمعت الليلة ذلك الكلام في الكون والإيجاب؟ فقال: يا حبيبي! إما أن
يكون هذا الرجل مرحوماً في أيديكم أو تكونوا مرحومين في يده. أما في بلدكم
مارستان؟ أما للسلطان شفقة على هذا الإنسان، أما له من يأخذ بيده وينصح له
في نفسه ويكسح هذا الجزء من عقله، إنا لله وإنا إليه راجعون؛ غُمَّ عليّ
باسمه عندنا بخُراسان، وطُنِزَ بنا به في تلك البلدان، وقد كان، والله،
يلوحُ خلل كبير لقوم من أهل العقل والأدب والحِكمة من رسائله ورِقاعه،
وكانوا يحملون الذّنب على الورّاقين.
وقال يوماً آخر لابن القطّن أبي الحسن الفقيه المتكلّم: أيها الشيخ أنت
على الحقّ؟ قال: نعم.
قال: واللهُ الحقّ؟ قال: نعم.
قال: فأنت على الله.
فقال القصّار: الحمد لله على سرعة هذا الانقطاع، وسُطوه هذا البُرهان،
ولُزوم هذا الحكم.
فلما خرج قلنا له: هلاّ فصّلت أيها الشيخ وقد عرّض بك، وتضاحك عند الإشارة
إليك؟ فقال: وما مُنا قَلتي رجلاً لو كان في المارستان مغلولاً لكنت لا
آمن جانبه إذا كلّمته، فكيف وهو مُطلق مطاع، ونعوذ بالله من مجنون قادر
مُطاع، كما نعوذ به من عاقل ضعيفٍ مَعْصيّ؛ ثم قال: وهذا الكلام من صاحبه
سوء أدب، وضعف عقل، وجَسارة نفس، واجتلاب مقت، وقلّة دين؛ إن الحقَّ الحقّ
اسمان يقعان بالاشتراك في اللّفظ على معنيين مُختلفين، وأنا على الحق،
ولكن الحق الذي ضدّه الباطل، ولستُ على الحق الذي لا ضدّ له؛ والحقّ يُطلق
على الله ويُراد أنه محقِّق، والحق يُطلق على ما عداه ويُراد به أنه
محقَّق؛ والله الحق المُحِقُّ المحقِّقُ، وما جاوزه فهو الحق المُحقّ
المُحقَّق؛ وإذا قيل في وجهٍ آخر: الله محقَّق فالمراد به غير هذا، لأنه
يُراد به أنه مُثبت موجود، ومعتَقَد مشهود له بالوحدة والقدرة والحِكمة
والمشيئة.
وحدّثنا ابن عباد يوماً قال:
ما قطعني إلا شابٌّ ورَد علينا أصبهان من بغداذ، فقصدني فأذنت
له، وكان عليه مُرقَّعة، وفي رجله نعل طاق. فنظرت إلى حاجبي، فقال له، وهو
يصعد إليَّ: اخلع نعلك، قال: ولم؟ ولعلّي أحتاج إليها بعد ساعة، فغلبني
الضحك وقلت: أَ تُراه يريد أن يصفعني بها.
وقال لي علي بن الحسن الكاتب: هجرني في هذه الأيام هجراً أضرَّ بي، وكشف
مستور حالي، وذهب عليَّ أمري، ولم أهتد إلى وجه حيلةٍ في مصلحتي، وورد
المهرجان فدخلت عليه في غمار الناس، فلما أنشد يونس تقدّمتُ وأنشدتُ، فلم
يهشّ لي ولم ينظر إليّ، وكنت ضمَّنتُ أبياتي بيتاً له من قصيدة على رويّ
قصيدتي، فلما مرّ به هذا البيت هبّ من كسله ونظر إليّ كالمنكر عليّ،
فطأطأتُ رأسي، وقلتُ بصوتٍ خفيض: لا تلم، ولا تزد في القُرحة، فما عليّ
محمل؛ وإنما سرقتُ هذا البيت من قافيتك لأُزيّن بها قافيتي، وأنت بحمد
الله تجود بكل عِلقٍ ثمين، وتهب كل جوهرٍ مكنون، أَ تُراك تُشاحُّني على
هذا القدر، وتفضحني في هذا المشهد؟ فرفع رأسه وصوته وقال: يا بُني أعد هذا
البيت. فأعدته، فقال: طنَّانٌ والله! يا هذا! ارجع إلى أول قصيدتك، فقد
سهونا عنك، وطارَ الفكرُ بنا في شيءٍ آخر؛ والدُّنيا مَشغلة، وصار ذلك
ظلماً لك لا عن قصدٍ منا ولا تعمُّد.
قال: فأعدتها وأمررتها وأطربتُ بإنشادها، وفَغَرتُ فمي بقوافيها؛ فلما
بلغت آخرها قال: الزَم هذا الفنّ فإنه حسن الدِّيباجة، وكأنَّ البُحتريّ
قد استخلفك، وأكْثُر بحضرتنا وارتفِع بخِدمتنا، وابذُل نفسك في طاعتنا
نكُن من وراء مصالحك بأداء حقّك والجذْب بضبعِك، والزيادة في قدرك على
أقرانك.
قال: فلم أرَ بعد ذلك لا الخير، حتى عراه ملل آخر، فعاد إلى عادته، ثم
وضعني في الحبسِ سنة، وجمَع كتبي وأحرقها بالنار، وفيها كتب الفرّاء
والكسائي، ومصاحف القرآن، وأصول كثيرة في الفقه والكلام، فلم يميّزها من
كتب الأوائل، وأمر بطرح النّار فيها من غير تثبّت، لفَرط جهله وشدّة نزقه.
أَ فهذا يا قوم من سيرة أهل الدين، أو أخلاق ذوي الرياسة، أو من جنس ما
يُعتاد ممن له عقل أو تماسك؟ وهَلاّ طرح النار في خزانة كتبه على قياس
هذا؟ فإن فيها كتب ابن الرَّوَندي، وكلام ابن أبي العَوجاء في مُعارضة
القرآن بزعمه، وصالح بن عبد القُدُّوس، وأبي سعيد الحصيري مع غيره من كتب
أرسطا طاليس وأشباهه. ولكن من شاء حَمّق نفسه.
كان الأقطع المنشد الكوفي يقول كثيراً: لو لم تستدلّ على جنون هذا الرّجل
وقلّة دينه وضعف عقله إلا بنفاقي عليه لكفى؛ لأني رجل قُطعت في اللّصوصية،
فما قولُك في لصٍ مقامر؟ أقودُ وأَلوط وأَزني وأنمُّ وأضرِب، وليس عندي من
خيرات الدُّنيا شيء؛ لأني لا أُصلي ولا أصوم، ولا أُزكّي ولا أحُجّ،
ونشأتُ في المساطب والشطوط والفُرض والمواخير، ومشيت مع البطّالين سنين
وسنين، وجرحت وخنقت وطررت ونقبت وقتلت وسلبت وكذبت وكفرت وشربت وسكرت
وشابكت وساكنت وماحكت ودامكت. ولم يبق في الدنيا منكر إلا أتيت، ولا خَنَى
إلا ركبت؛ وهو على هذا يُغريبي ويلجّ معي ويؤذيني ويمنعني من الرّجوع إلى
بيتي وامرأتي، قد حبسني في داره هكذا، فإذا اغتلمت جلدت عُميرة ضرورة.
وصدق هذا الشيخ، كذا كان مذهبه، وعليه شاخ، ولكنّ ابن عبّاد كان يتعلم منه
كلام المُكَدِّين، ومُناغاة الشحّاذين، وعبارة المقامرين ومن يصرّ في
اللعب بالكعبتين، ويضجر ويكفر وينخر ويشقّ المِئزر، ويبزق في الجوّ؛ وكان
لا يجد هذا عند أحدٍ كما يجده عنده، فلذلك كان يتمسك به.
وكان الكوفي هذا، مع ما وصفناه، طيّباً مليحاً نظيفاً فصيحاً، وهو الذي
حدثنا عن بعض أصحابه في المسطبة.
قال: قلنا له: إنك تُحب الطِّيب، وتلهج بالنكاح وتُفرط.
قال: فقال لنا: والله ما أقتدي في هذا إلا بنبيّنا صلى الله عليه، فأنه
قال: " حُبِّب إليَّ من دنياكم ثلاثة الطِّيب والنّسَاء " .
قال: فقلنا له: ففي الخبر: " وجُعلت قُرَّةُ عيني في الصلاة " وأنت لا
تُصلّي أصلاً.
فقال: يا حمقى لو صلّيت لكنت نبياً، وقد قال صلى الله عليه: " لا نبيَّ
بَعْدي " .
ورأيتُ الأقطع هذا واقفاً بين يدي ابن عبّاد في صحن الدار، وذاك أيضاً
واقف، فطلع أبو صالح الورّاق، فقال ابن عباد حين نظر إليه وإلى لحيته
المسرّحة:
ولحيةٍ كأنّها القِباطِي
فقال الأقطع بلاّ وقفة:
جعَلتُها وقفاً عَلَى ضراطي
وكان أبو صالح هذا يقول: أنا من ولد محمد بن يزداد الوزير.
وكان ابن عبّاد يطالب الأقطع بأن يحفظ قصائده في أهل البيت ويُنشدها الناس
على مَذهب النَّوْح، وكان يُعطيه على كل بيت درهماً، وإذا لم يُحكِم ضربه
لكلّ بيت ضربةً بعصاً عَجْراء. فكان الأقطع المسكين كلّ يوم يُضرب.
فقلت له: من كلفك الصبر على هذا الضرب؟ احفظ كما كُنت تحفظ واربح
الدّراهم، وتخلّص من الألم.
فقال: والله لو ضربني بكلّ عصاً في الأرض كان أخفّ عليّ من حفظ شعره
الغَثّ، وإنشاد قافيته الباردة، والله وإن شعره في أهل البيت خِراء. فهذا
قوله.
وكان لا يدع الأقطع لينصرف إلى منزله، وكان يشكو الشبق، وكانت امرأته
تأتيه في كل قليل إلى دهليز الباب وتُغيّر ثيابه، وتُصلح أمره، وتحدّثه
وتنصرف بشيء معه قد جمعه فصادف الأقطع يوماً الدهليز خالياً، وكانت
الهاجرة منعت من الحركة، فراودها وطرحها في المكان المُتَخطّى وتقمّمها
وأخذ في عمله، فرمقه بعض السِّتريين فعَدا ورَفَع الحديث إلى ابن عباد،
وذكر الحال والصورة، فهاج من مقيله البارد ومكانه الظليل، وحَشيته التي قد
استلقى عليها، حاسِراً حافياً، قد جعل طرف كمه على رأسه بلا سراويل،
ولَقَط قدمه لقطاً حتى وقف على الأقطع وهو يكوم يُولج ويُخرج ويرهز ذاهب
العقل.
فقال له: يا أقطع ويلك يا ابن الزّانية إِيش هذا في داري!؟ فقال: أيها
الصاحب! اذهب ليس هذا موضع النظارة، هذه امرأتي بشهود وعُدول وعقد وقبالة،
اذهب اذهب، يَهذي ولا يعقل حتى أفرَغَ، وسيّدي على رأسه يضحك ويصفّق
ويرقص. ثم أخذ بيده على تلك الحال، وهو يشد تكَّتَه، وابنُ عباد يُعينه،
وأدخله إلى مقيلة يعاتبه ويسأله عن العمل والحال؟ وكيف استطابه وكيف هاج؟
ثم خلع عليه، ووَهب لامرأته ثياباً وطيباً.
أَ فهذا من المروّة والفضيلة وأدب الرياسة وآيين الوزارة؟ أَ هكذا كانت
البرامكة وهو لا يرضاهم؟ أم هكذا كان حامد بن العباس، والعباس بن الحسن،
وآل الفرات، وآل الجرّاح، وهو لا يزنهم بشيء فيمن تأخّر؟ إن من يستحسن هذا
وأمثاله، ويعذر أهله في الرياسة والجلالة لَضعيف النَّحيزة سليب المروّة؛
وإن من ينظر هذا وشبهه لصفيق الوجه قليل المعرفة.
وقال لابن الزيّات المتكلّم يوماً في مناظرته: لا تعبثْ بلحيتك.
فقال ابن الزيّات: وما عليك منها؟ هي لحيتي.
قال: أنا سلطان.
قال: أَ في عهدك النظر في لحيتي؟ قال أصحابنا: بل قال له: أنا سلطان، وإذا
خرجتَ من عندي ولحيتك على غير الشكل الذي دخلت عليّ به ظنَّ الناس أني
ظلمتك فيها عند المناظرة والخلاف، وأنا أحب صيانتك وصيانتي عند الناس
بسببك.
وقلتُ لابن الزيّات ببغداد: كيف رأيت ابن عبّاد؟ قال: هو كالحِر، لا يرجع
إليه من خرج منه.
وقلت للجيلوهي الشاعر، وكان شيخاً له تجربة ومعرفة بأيام الناس ومَشاهَدة:
حدِّثني عن ابن عباد.
قال: مغرور من نفسه لمواتاة جده، وتصديق ذوي الأطماع في جميع دعواه، وما
أحوجه إلى إنصاف الناس من نفسه بأحد شيئين: إما بأن لا يدّعي الكمال، أو
بأن لا يُبكِّت الرجال؛ فلا هو بريءٌ من النّقص، ولا هو غير مُستحق
للتَّبكيت؛ وليس من لا يمكن أن يواجه بالنقص الذي فيه وبالتوّبيخ الذي
يستحقه على فعله، ليدٍ له في السلطان قوية، وشمسٍ له في الدولة طالعة -
ينبغي أن يركب هاك الناس ويأكلهم بلسانه؛ فريح الدولة قد تركُد، والضَّعف
يزول، والحَشَم يتحوّل، وقد يُقال وراء ظهره ما يُربي على ما هو عليه، ولو
قصر يده على فضله الذي له لم تَشَلَّ، ولو وقف قدمه عند غايته لم تزل،
ولكنه يجري طلقاً ثم يكبو، وينصلت للقراع ثم ينبو، ويتطاول إلى ما لا
يناله ثم يخبو؛ وهذا طريق الجاهلين المغترين.
ثم قال: والكذب من آفاته، وهو خُلق يَعرُّ المروّة ويشين الديانة، ويسقط
الهيبة، ويجلب الخِزي، ويستدعي المقت، ويقرّب الموت؛ وقلّ من لهج به إلا
كان حتفه فيه، وما رُئي شيء أمحَى لنضارة الوجه ولبهجة العلم ولزينة
البيان منه.
قال: وعلى ذلك فما رأيت رئيساً يُحسن ما يحسن من الإحسان إلا هو مردود
بالتنكد، لأنه ما هنّأ قطّ بنعمته، ولا أمتع بإحسانه. ولا ترك له يداً
بيضاء عند أحدٍ إلا وكرَّ عليها بالتسويد.
قال: وقد شاهدتُ النّافقين عليه، والمتقدّمين لديه، ووقفت على
مَوَاتِّهم ووسائلهم وأسبابهم وذرائعهم فلم أجد فيهم إلا مَخْشيَّ اللسان
استكفّ شرّه بالإحسان كالخوارزمي وغيره، أو مرتبطاً لأمر يُراد منه لا يفي
به سواه كالهمذاني ومن جرى مجراه، أو ملعوباً به قرّب على ظنّه وريبة
وحالٍ زائدة على القُبح والفضيحة، كفلان وفلان وهم الدُّهم؛ ولم أجد في
ضروب المتوسّلين إليه، بعد هؤلاء، من وَصَل إلى درهمٍ من ماله إلا ببذل
النفس وإذالة العِرض، ومواصلة البُكور والرّواح واستنشاق الغبار والرياح
وتجرع العبط والكد، ومزاحمة أهل الجهل والنقص، ومُغالبة ذُلّ الحجاب وسوء
أدب البوّاب والرضا بالهزء والسخرية؛ وما ابيضت له يد عند أحد، ولا تمّت
له نعمة على أحد، لملله وحسده، وضجره ونكده، وامتنانه وكثرة ذكره لفضله
ومدحه لنفسه. والعرب تقول في حِكَمها: المنّة تُزرِي بالأَلبّاء.
على أن عطاءه لا يزيد على مائة درهم وثوب إلى خمسمائة، وما يبلغ إلى ألف
نادر، وما يُوفي على الألف بديع، بل قد نال به ناس من عرض جاهه على السنين
ما يزيد قدره على هذا بأضعاف، وعدد هؤلاء قليل جداً، وذلك أيضاً بابتذال
النفس وهتك الستر، والإفراج عن الدين والمروة والعِرض والأَنَفة.
قال: وأي عقلٍ يكون لمن يقول: لم يكن في الدولتين الأموية والعباسية مثلي،
وهذا الكلام قد دوّنه في بعض كُتُبه؛ وقد حكيتُ هذا بمدينة السّلام فسمعه
قومٌ كرام يرجعون إلى فضل كثير وبصائر حسنة منهم ابن البقّال الشاعر،
ومحسِّن ابن التَّنوخي، وابن فتاش المصري فضحكوا وهزئوا، وشعثوا عرضه،
وجحدوا محاسنه التي لو سكت عليها لسلمت له، ولادّعى في جملتها أكثر مما
يدّعيه لنفسه؛ ولعمري ما كان له فيمن تقدّم في الدولتين مثل ولا شبيه،
ولكن في الخلاعة والمجون، والرَّقاعة والجنون.
قال: ومن العجب أنه يدّعي " العدل والتوحيد " وهو لا يُفيق مِن قَتْلِ مَن
ظَنَّ به عداوته والوقيعة فيه، أو القدح في رُقعةٍ له، وإن كان ذلك
الإنسان من الصالحين العابدين.
ولقد بلغ من ركاكته أنه كان عنده أبو طالب العَلويّ، فكان إذا سمع منه
كلاماً يسجع فيه، وخبراً يُنمّقه ويرويه، يبلق عينيه وينشر منخريه، ويُري
أنه قد لحقه غَشيٌ حتى يُرشّ على وجهه ماء الورد. فإذا أفاق قيل له، ما
أصابك؟ م عَراك؟ ما الذي نابك وتغشّاك؟ فيقول: ما زال كلام مولانا يروقني
ويُونقني حتى فارقني لُبّي وزايلني ذِهني واسترخت له مفاصلي وتحلّلت عُرى
قلبي وذهل عقلي وحِيل بيني وبين رُشدي؛ فيتهلّل وجه ابن عبّاد عند ذلك،
وينتفش ويضمحل عجباً وجهلاً، ثم يأمر له بالتكرمة والحِباء والصِّلة
والعطاء، ويقدمه على بني عمه وبني أبيه.
من ينخدع هكذا فلا يكون ممن له في الكتابة قسط، أو في التماسك نصيب، وهو
بالنساء الرُّعن والصبيان الضعاف أشبه منه بالرؤساء والكِبار.
وحدثني الشاذياشي قال: حُجبت مدة عنه فضقت ذرعاً بذلك، فإن الجاه الذي كنت
مَدَدته انزوى، والأمر الذي قوّمته تأوّد، وأخذت المادّة تقف، والحال
ينقص، والذِّكر يقلّ، فأحييت الليل أرقاً وفكراً فيما أعتلّ فقدح لي
الخاطر بحيلة، فأصبحتُ وكتبت رقعةً ذكرت فيها: " إني رجل امتُحنتُ بما لم
يمتحن به أحد غشي بابك، ونال إحسانك واستمرع فناءك، واستحصد جنابك؛ إني
بعد هذا الدأب الشديد والنَّصب المتّصل، والقراءة والنَّسخ، والبحث
والمناظرة، والصَّبر والمناصحة، قد شككت في مسائل " الأصول الخمسة " التي
عليها مدار المذهب، وركن المقالة، وهذه محنة بل فتنة، بل شيء فيه هلاكي
وخُسران عملي، فالله الله فيّ، تداركني فإني من الأموات بين الأحياء، غريب
الدّار، خائب الأمل، بائر البضاعة، خاسر الصّفقة، طلبت الزيادة على ما كان
عندي فأتلفتُ ما كان معي " .
قال: فلما قرأ الرُّقعة قلق في نصابه، وأقبل على أصحابه وقال: مسكين
الشاذياشيّ لقد نزل به أمر عظيم، وحلّ به خطب جسيم، ودُهي في دينه، وأُصيب
بيقينه؛ إن هذا لهو البلاء المبين. عليَّ به، هاتوه البائس. ودُعيتُ
فأدْناني ولا طفني، وقال لي: ما هذا الشكّ الذي اعتراك، وأين أنت عن
القاضي أبي الحسن حتى يحلّ ذاك؟ قلتُ: لستُ أثق إلا ببيان مولانا، ولا عجب
من بيانه، ولكن العجب من إنصافه مع سلطانه، وحُسن إقباله مع أشغاله.
قال: فانفسخَ عقده، وابتلّ شنُّهَ، واستحال ذلك المللُ استطرافاً
وذلك النُّبوُّ استعطافاً، وأقبل يقول: هاتِ، وأنا أهاتيه هكذا أياماً
وليالي، أَتأطَّر له تارةً بالاستحسان والقبول، وأتعسّر عليه تارة
بالتوّقف والفتور، ولا أفارق الكيْس والحيلة، حتى استنفدتُ قوّته وقوتي
له، ثم قبّلت أطرافه وتباكيتُ، وقلتُ: يا مولانا أسلمتُ على يدك، ونجوت من
النار بإرشادك.
فقال: يا أبا عليّ! اكثُر عندنا، واقتبس علمنا، قد ذلّلنا لك الحجاب،
وتقدّمنا بذلك إلى الحُجَّاب، فاسكن واطمئن، وطب نفساً وارفئنّ، ولا تقلق
فترْجَحِنّ.
قال: فانصرفت من مجلسه قرير العين، ممدود الجاه، مملو اليد، ونفسي ريّا
بكل أمل، وتفتّحت عليّ أبواب الرّزق، وجمعتُ إجّانة كبيرة خضراء دنانير.
قال الجيلوهي: وحديث هذا الرجل ذُو شجون، على أنك إذا أنصفت لم تجد له
نظيراً في دهرك، ومتى بُليت به طلبت الخلاص منه ولو بفقرك.
قال: وما أخوفني أني إذا دفعت إلى غيره بعده تمنَّيتُه، فأكون كما قال
الشاعر:
عتَبتُ عَلَى بشرٍ فلما فقَدتُه ... وجرَّبت أَقواماً بَكيْتُ علَى بشْرٍ
هكذا أنشد، وغيره يُنشد: " على عَمرو " ؛ والصحيح " على سَلْم " وله حديث.
قال: ومن خواص ما فيه حُبّه للعامّة، وذاك بقدر بغضِهِ للخاصّة. وقد قال
يوماً: أنا أعلم أن الحجاب قبيح وبغيض، والصبر عليه متعذّر، وهو الذي
يُورث العداوة الشديدة، ويبعث على القالة الشنيعة، ويمحو كلّ حسنة،
ويُهجِّن كل نعمة، ويثير كلّ نقمة، ويُبدي كلّ عَورة، ويُبرز كلّ سوأَة؛
وقد دُهي الناس منه قديماً وحديثاً، لكنّي أتلذّذ به، ولستُ أجد طعم هذه
المرتبة العلية، ولا أعرف ثمرة هذه الحال السَّنية إلا بعد أن أحتجب ويقف
الناس على منازلهم بالباب، وأعلم أن صدورهم تغلي بالغيظ، وألسنتهم تجري
بالعيب، وأهواءهم تأْتلف على القِلى والبُغض؛ فإن الحديث ينخرق بكل معنىً
إلى سوء، ولكن لا أسمح بحلاوة الدولة، وبجلالة الصَّولة، وبهيبة المكانة،
وبما أن سهوت عنه صرتُ إلى المهانة.
قال هذا الشيخ: وهذا قول من نصّ الله على خذلانه، وأسلمه إلى حوله، وأنطقه
بلسان إبليس الذي هو عدوّ الله، ولا شكّ أن هذا المذهب من علامات الشَّقاء
في الدنيا، وآيات الخُسران في العاقبة، ولن يُقدم عليه إلا من قد سمح
بعرضه، واستهان بشنيع القالة في نفسه وأبيه وعمّه وأُسرته، وجميع من ضَرَب
في مذهبه بسهم، وشابهه بوجه.
وحدثني ابن الثلاّج المتكلم، وكان ديِّناً صدوقاً، قال: العجب أن ابن
عبّاد يدّعي أنه قرأ على شيخنا أبي عبد الله البصريّ، ولقد كذب في دعواه
وفجر في قوله؛ لقد ورد علينا بغداذ وهو ينصر ابن كُلاّبٍ على حدّ
المبتدئين، فحمله مِسكَويه إليّ، ثم دخل الواسطيّ عليه وفتح باب المذهب
له، ولم يكن غير ذلك.
وكان أبو عبد الله لا يعرفه ولا يعدّه، لأنه كان لا يدري ما يكون منه
ويصير إليه في الثاني.
وما قدرُ كُويتبٍ يرد مع صاحبه، لا سنَّ له ولا شُهرة، ولا إفضال ولا
توسُّع، ولا حاشية ولا حَشَم؟ ودارت الأيام ودالت الأحوال، فكتب هذا الشيخ
إلى هذا الإنسان بعماد الدين؛ وأنا أبرأُ إلى الله من دين هذا عِمادُه؛
وكتب هذا إلى ذاك بالشّيخ المُرشد، وأيُّ إرشادٍ كان عنده؟ وكيف يكون
مُرشداً من ليس برشيد؟ وكيف يكون رشيداً من لا يُفارق الغيّ؟ إن كنت تشكّ
في أمره فانظر إلى غِلمانه: الرَّازي، وابن الغازي، وابن طرفان، والبزاز،
والنَّصيبي أبي إِسحق، والصَّيرَفيّ، والهَمَذانيّ، والدّامغِانيّ، عِصابة
الكُفر، ما فيهم من يرجع إلى ورع وتُقىً، أو إلى مُراقبة وحَياء أو هدى.
ولقد رأيتُ أبا عبد الله البصري في مجلس عِزّ الدولة سنة ستين في شهر
رمضان، والجماعة هنا: أبو حامد المرورّوذي وأبو بكر الرّازي، وعلي بن
عيسى، وابن نبهان، وابن كعب الأنصاري، والأبهَري وابن طَرَارَة، وأبو
الجيش شيخ الشيعة وابن معروف وابن أبي شيبان، وابن قُريعة، وناسٌ كثير،
وهو في إيوانٍ فسيح في صدره مَنْ حَضَروا من أجله، وأبو الوفاء المهندس
نقيب المجلس ومُرتّب القوم.
فسئل البصري في مسألة فأظهر أنه في بقية علّته، وأنه لا يقدر على الكلام.
ثم قام عليّ بن عيسى الشيخ الصالح وقال: هذا مجلس يُبتهى بحضوره
لشرفه، ويُفتخر بالكلام فيه لكثرة من يعرف ويُنصف، والمُغالطة فيه مأمونة،
وليس في كلّ أوانٍ يتّفق هذا الجمع، وبيننا وبين هذا الشيخ، يعني أبا عبد
الله، مسألة من أجلها ومن أجل نظائرها قد استجاز تكفيرنا وتفسيقنا
والتَّشنيعَ علينا وتنفير المقتبسين منا، وها أنا قد ابتديتُ سائلاً
فلينصُر مذهبه كيف شاء، وإنما هو دينٌ، فيجب أن نبحث عنه من العارفين.
فقال عزُّ الدولة: كلام منصف، ما أسمع بأساً ولا أرى ظِنَّة، يحثُّ بذلك
على الجواب.
فاصفرَّ أبو عبد الله وقلق، وفطِن أبو الوفاء وكان ضَلْعُه معه، وصَفُوه
له، فحال بينه وبين الأمير وقال: الشيخ عليل، وإنما حضر للخدمة، وبعض
غلمانه ينوب عنه، ولا ينبغي أن يتعَب فيحْمى جسمه، ويُخاف نكسُه، ويصير ما
قُصد من قضاءِ حقه في التجمُّل بحضوره سبباً للتألم.
ثم أقبل أبو الوفاء على عليّ بن عيسى فقال: يُكلّمك أيها الشيخ من غلمانه
من تُحب.
فقال: لا حاجة إلى الكلام مع غلمانه، إنما كان الكلام معه هو القصد، لأن
الاجتماع بيننا يقلّ، ولأن الخصومة تكون معه الفيصل، وذاك أنه يُكتب كلامي
سائلاً، وكلامه مُجيباً، ثم لا نزاع.
فأما أصحابه فإنهم يكلّمون أصحابي وذاك قائم بينهم، وكانت البغية قطع
المادّة، وحسم الشَّغب، وبلوغ الحدّ، وإذا وقع الإباء فلا لجاج، وإذا عُرف
المراد فلا حجاج.
ثم قال عزّ الدولة: هاتوا شيئاً آخر قبل أن يتصرَّم النهار بما ليس له
درٌّ، وكان فصيحاً.
فأعرض أبو الجيش الخراساني وكان متكلّم الشيعة، فسأل عن القرآن وقال:
أروني من القرآن تنزيله على هيئته الأُولى حين نزل به جبريل على قلب محمد
صلى الله عليه، فتلاه على أُمّته بلسانه، فإني أجد عند حمَلَته اختلافاً
كثيراً في تحريفه وتصحيفه، ونقصه وزيادته، وإعرابه وغريبه ووضعه وترتيبه؛
ولهذا وأشباهه اختُلف في تأويله، وشُكّ في تنزيله، وكثُر خوضُ الناس فيه
وفي تفسيره، والاحتجاج له؛ ولقد سبَق علمي أن كلام الله لا يكون في حكم
كلام عباده، وأن ما يجوز على ذلك لا يجوز على هذا، لأن الله حكيم كريم
رحيم، والحكمة والكرم والرحمة تأبى ما تصفون به في كتاب ربّكم، وتستجيزونه
في كلام خالقكم.
قال: وهذا الذي قلتُ بيِّن معروف؛ القرأَةُ تختلف ضرباً من الاختلاف،
والنَّقلة تختلف ضرباً آخر، والفقهاء تختلف على قدر ذلك ضرباً آخر، وكذلك
أصحاب الكلام؛ وحتى أفضى هذا إلى طعن الزّنادقة فيه، وانجرَّ عليه قدح
الملحدين به، وقال كلاماً كثيراً من هذا الجنس، فكلّهم كاعَ عن الجواب،
وكاد أبو الجيش بعد تذرُّعه بالقول يشمتُ ويبالغ في التَّشنيع.
فقال عزّ الدولة: يا أبا الجيش أنت في معركة لا مُبارٍ لك فيها، فافرِ كيف
شئت وذر، والله المستعان.
فانبرى أبو حامد وتكلّك بملءِ فيه، ومحق أبا الجيش وبيّض وجوه الناس.
فلما خرج قال له محمد بن صالح الهاشميّ: لقد دعمت الإسلام بدِعامةٍ لا
يُزعزها الزّمان، ولقد حصّنت الدين حَصانةً الله يُجزيك عنها، ورسوله صلّى
الله عليه يُكافئك عليها.
ولولا أن هذه الرسالة لا تحتمل المسألة والجواب بما فيها من فنون القول
لأتيتُ بالمجلس على وجهه.
فهذا كان اقتدار البصري جُعل في المناظرة، وقوّته عند لقاء الخصم ونُصرة
المذهب والدّين.
ولقد ذَكَا عيناً عشرين سنة على صاحب بغداذ لصاحب... حتى آلت الأمور إلى
ما عرفه الصّغير والكبير بأصحابه أصحاب المحابر والأقلام والكرارس.
ولقد بلغ من قلة دينه أنه صنّف رسالة ذكر فيها الدّلالة على أنه هو المهدي
المنتظر. قال: فإن معنى المهدي أن الله هَدَاك، وهدى أهل العدل والتوحيد
لك؛ وأما المنتظر فلأَنّا كنا ننتظرك بالعراق؛ وهذه الرسالة مشهورة وحُملت
في جُملة الهدايا إلى قابوس.
وسمعت أبا محمد الفرغاني الحنيفي يقول: ما خلوت بفكري في أمري ومُلازمتي
هذا الرجل - يعني البصري - إلا ظننتُ أن الله تعالى يرسل عليّ صاعقة أو
يجعلني آية وعبرةً باقية.
وأما ابن أبي كانون فإني قلت له يوماً: مالي أراك واجماً من غير
عارضٍ، وطويل السكوت من غير عيّ، وكثير الفكر من غير وسواس، وشديد الحُزن
من غير إفلاس؟ ليس لك أُنس بالجماعة، ولا تفكُّه بالمحادثة، ولا استماع
بالمجالسة، بعد ما عهدتك في حدثان مقدَمك وأنت تتَّقد كالنار، وتزخر
كالبحر، وتأرَنُ كالمُهر، وتذكو كالقنبر.
فقال: ومن أولى بالبال الكاسف والغمّ الطويل والأرق الدّائم منّي؟ فارقتُ
وطني وأهلي وإخواني ومعارفي وجميع ما كنت آلفه وأحيا به، وأشتمُّ روح
العيش منه، وتجرّعتُ مرارة بُعدي عنهم، وصبرتُ نفسي على ما نالهم بخروجي
من بينهم وسلوتي دونهم، وما نزل بي بعدهم من جفاء الغُربة ووحشة الوحدة،
وشَظف العيش بالقلّة - كلّ ذلك طمعاً فيما أًبرّد به غليل قلبي في الدّين
والمذهب، وأنفي به الحَرج من صدري وأسعد، وأن آخذ من هذا الشيخ ما أهتدي
به وأسكن إليه، وأجعله عُدّة لآخرتي. والآن قد حصلت - بعد الرسالة الطويلة
والمنازعة الشديدة وبعد البحث ولنّظر والكشف والجدل، وبعد اعتبار هذا
الشيخ في نفسه وسيرته وما عليه أصحابه والمتقدّمين عنده - على حالٍ عسراء،
وغايةٍ عمياء، وما أراه إلاّ صاحب دنيا يعمل للعاجلة، ولا أرى أصحابه
المُطيفين به إلا كذلك، وإن هذا مما يؤلم القلب، ويُفرَّق البال، ويحشد
الهمّ، وينفّر اليأس؛ فلذلك ما تراني على غير ما عهدتني عليه.
وأما ابن بُنان الورّاق فإني سمعته يقول: لقد خطب البصري على الإسلام بما
لا يقدر عليه الرّوم والتّرك.
قلت: وكيف ذاك وأنت لا ترى اليوم ببغداذ مجلساً أبهى من مجلسه، لما يجتمع
فيه من مشايخ العراق وشبّان خراسان وفقهاء كل مصرر، وما في هؤلاء أحد إلا
وهو يصلح أن يكون داعية صُقعٍ وإمامَ بلد؟ فقال لي: صدَقت، فهل تعرف فيهم
من إذا ذُكر الله وجِل قلبُه واقشعرّ جلده، واطمأنّ صدره؟ وإذا سمع موعظةً
دمعت عينه وخشعت نفسه أو سُمع نشيجُه؟ وإذا عرضت له منالة عفّت نفسه؟ أو
إذا هاجته شهوةٌ اتّقى عندها ربّه؟ أو إذا لزمه إنكار أمرٍ بذل فيه وُسعه.
أما ترى اللّعب والمزاح والسَفه والقِحة والتَّجليحَ والفسق والفجور
فاشيةً فيهم، وغالبه عليهم، وظاهرة بينهم؟ أما لك في الرازي أبي الفتح
عِبرةً؟ أما لك بابن طَرْخان خِبرة؟ فما زال يقول هذا وأشباهه حتى سدّدتُ
وقطعتُ عليه.
وكان أبو إسحاق النّصيبي من أفسق الفاسقين، وهو يُلقّب بُمقعدة، لا أعلم
في الدنيا قاذورةً إلا أتاها، ولا خساسة إلا أظهرها وجاهر بها، هكذا كان
ببغداذ، ثم بالدِّينَوَر عند أبي عمرو كاتب فخر الدولة الإصبهاني، وحديثه
بإصبهان مشهور، وكذلك بالصّيْمَرة، وكيف أكل في نهار شهر رمضان من غير
عُذر، وكيف تهتّك بجماعة من الأحداث. نعوذُ بالله من الخذلان.
وحدثنا أبو سليمان محمد بن طاهر السِّجستاني، وكان بعيداً من التَّزيُّد
شديد التّوقي، قال: حضرت وليمة في قطيعة الربيع، فلقيني فيها البصري أبو
عبد الله، فجلس إلى جانبي، وتصرّف في الحديث معي، وأرخى عنانه إليّ إلى أن
قال لي: يا أبا سليمان، هل وجدتم في فلسفتكم شيئاً تسكنون إليه، وتعتمدون
عليه؟ فأنا من الكلام ومَذاهب أهل الجدل على غُرور.
قال: فسكتُّ من أجل الموضع، وقلتُ:
الناس أَخيافٌ وشتَّى في الشّيَمْ ... وكلهم يَجمعهم بيتُ الأَدَمْ
فقال: آخِرُ ما عندي أن الأدلّة تتكافأ، وأن المذاهب والآراء والنِّحل
جارية بين أربابها على قوة النتائج وضعفها، وجودة العبارة ورداءتها.
قال: وقلتُ له: ما بعد نظرك نظر، ولا بعد تحصيلك تحصيل، وانتهى.
وأمثل من شاهدناه عندنا ببغداذ: الواسطيّ أبو القاسم. وكان يبرأ إلى الله
من البصري جُعَل، ويلعنه عند الوليّ والعدوّ تقرباً إلى الله.
وكان ابن الثلاّج يقول: حكَم الله بيننا وبين ابن عباد وفلان، فإنهما
سلّطا هذا الإنسان في هذا المكان حتى أفسد من أجابه إلى المذهب، ونفّر من
أراد أن ينظر في " العدل والتوحيد " .
وسمعتُ الفرغانيّ يقول: لولا أني لا أعرف في جميع المذاهب أقوى
من مذهب المعتزلة لَناديتُ على أصحابي بمخازيهم التي يشتملون عليها
ويُجاهرون بها، في الأسواق والشوارع، بل في المَحاضِر المشهورة والمنابر
الرفيعة، ولكن لهم حُرمة الدعوى وذمام النّسب إلى المقالة، ورجاءٌ في
الإقلاع والتّوبة، فإن اليأس غير غالب ما دامت الاستطاعة موجودة،
والنُّزوع ممكناً، والتّلافي مظنوناً.
ذاك حديث ابن عباد، وهذا حديث شيخه وإمامه ومُرشده بزعمه، وهو المرشد
والهادي لمن أخذ عنه واقتدى به. يا قوم! أين يُذهب بكم؟! ما هذا العَمَى
الذي قد غلب عليكم، والهوى الذي قد أصمّ آذانكم وأعمى أبصاركم؟ وماهذا
الأمر الذي قد حال دون العيان، وطمس وجه الرُّشد، وقلب أثر الحسّ؟ أَ ليس
هذا القائل في مُجونه وتلعُّبه بدينه:
مِن عَملِي مِن عَملِي ... نيكُ الرّجال البُزَّل
وإِنما أَنِيكُهم ... لأَنّني مُعتَزِلي
تلميذُ شيخٍ فاضلٍ ... مُلقَّبٍ بالجُعَل
أَ فهكذا يكون من كان عماد الدّين، وناصر الإسلام والمسلمين؟ الويل له، ثم
الويل لمن يتولاّه وينصره.
قال يوماً لابن فشيشا صاحب مَصْطَبَةِ المُكْدين بالريّ:
لا تُبطئَنَّ عن اللذات إِن حضَرت ... لكن تَبَنَّك ولا تحفل بتأَنيب
ولا تَزُقّ إذا ما نِلتَ ذاك وبت ... مع شَوْزَرٍ وافر الأَرداف محبوب
فالصَّمْي والمَتْرمن بعد القُشام به ... طيبُ الحياة فلا تعدِل عن الطيب
خذ في القُشام وخذ في الصَّمي بالكوب ... فالدَّهر يمزج تكسيحاً بتهريب
أَ فهذا كلام من يدعو إلى الله، ويُحبُّ أن يُستجاب له، ويُجرى على
طريقته، ويكون ذريعةً بين الله والعبد؟ هذا - عافاك الله - باللعنة
الأولى، وبالبراءة منه ومن أصحابه أحقّ. ما أقلّ حياء هؤلاء وأشدّ تكاذبهم
ومكابرتهم! وإذا ضربت عن باب الدّين، ورجعت إلى الكفاية التي زعم أنه بها
تكفّى، وأنه كافي الكُفاة، وأنه واحد الدنيا.
هل كان يعرف من الحساب باباً؟ هل عقد جماعة؟ هل عُقدت له فتكلم عليها؟ هل
قرأ مؤامرة؟ هل عرف منها حدٍ؟ هل أمكنه أن يحتجّ على عامل أو يناظر
ناظراً؟ أو يُخاطب مُشرفاً، أو يرسم في العمل رسماً، أو يُجيب عن كتابٍ
واحد في العمالة؟ وفيما يتعلق بأبواب النظر في العمارة، هل ناظر خائناً
مُتقطِعاً، أو استدرك مالاً مُختلساً؟ هل فصل حكُومة بين كاتبين، أو قطع
خصومة يبين جُنديين؟ هل رأينا ثَمَّ إلاّ الرَّقاعة والتدفق، والجنون
والهذيان، والتَّسايل والتمايل، والبقبقة والطقطقة، والقرقرة والبربرة؟
إلا أنه غُلط فيه ووُثق به، ووُكل إليه الرأي، ولك يؤذن لأحدٍ في تحريكه
بكلمة، ولا في مضادّته بحرف، حتى تمّ له ذلك كله بأسهل وجه مع الجوّ
المُواتي والأمر المُنقاد، وحُب أن يعتقد أن ذاك عن كفاية في الصناعة
وحِذق ٍ في العمل، وسعة علمٍ بالكتابة الدّيوانية والرّسوم الخراجية.
وسُئل يوماً عن قول الشاعر:
سَقَوني النَّسْيَ ثم تكَنَّفُوني ... عُداةَ الله مِن كَذِبٍ وزُورِ
فقال: الخمر تسمّى نسْيا.
فقيل له: ولم؟ فقال: ليس للأسماء علل.
فلما خلوت بالزعفراني الشاعر قال لي: أخطأ، فإن الأسماء ضرب منها مُبتدأ،
فالغرض فيه اختصاص العين به ليقع التمييز بينه وبين غيره، وضرب آخر يؤخذ
من أصل الفعل وهو الذي سمي مُشتقّاً لتكون فيه دلالتان: دلالة كدلالة
الأول في اختصاص العين، ودلالة على النعت.
والنَّسي في أسماء الخمر من الضرب الثاني، لأن الخمر تنسأ العقل أي
تؤخّره، وقال: هذا قاله بعض العلماء.
فقلتُ له: هلاّ قُلت هذا في المجلس؟ فقال: لو قلت هناك لما وجدتني عندك
قاعداً مطمئناً.
قلتُ: صدقتَ، الرجل حسُود.
فقال: ولربّه كَنود، ولآياته عَنيد، كأنه من اليهود، أو من بقية ثمود.
ولقد غضب يوماً م شيء رواه المِصريّ، وحجبه أياماً؛ وذلك أنه روى أن
امرأةً جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فيما رواه عبد الله بت عمرو بن
العاص، فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وِعاءً، وحجري له
حِواء، وثديي سِقاء، وزَعَم أبوه أنه ينزعه مني.
فقال رسول الله صلى عليه وسلم: أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي.
وكان غضبه من الحسد، لأنه روى هذا في عُرض حديثٍ بفصاحةٍ وتسهّل.
وله مثل هذا كثير، كان لا يستطيع أن يسمع من أحد كلاماً منظوماً.
قال لأبي السلم مسلم الأعرابي يوماً: ما خبرُك مع فلان؟ قال: انقلبتُ عنه
خاسئاً وأنا حسير.
قال: لا تنتجع أمثاله.
قال: أيها الصاحب، ما أعلمني بمظانّ الرَّجاء والخيبة! ولكني ربما اغتررتُ
بالشكّ اغتراراً، وانجررت على الشوك انجراراً، وآخر دعواي أن الحمد لله
الذي لم يقطع أمَلي من خيره حتى غمرني بأيادي غيره، وذاك أنت.
وكان حسده لغيره على فصلٍ حسن، ولفظٍ حرّ، بقدر إعجابه بما يقوله ويكتبه؛
كتب يوماً إلى إنسان: " وأُقسم أنك لو كتبتَ بأجنحة الملائكة المقرَّبين
على جِباه الحُور العِين، مستمداً من أحداق الولدان المخلّدين، جوازاً على
الصّراط المستقيم إلى جنّات النَّعيم لما حَسُن هذا البخل " .
فأخذ يُعيد هذا ويُبديه، ويقول: كيف ترون؟ وكيف تسمعون؟ وهل قرأتم شبيهه؟
وروى في مجلسه يوماً ابن ثابت البغدادي حكاية الخليل، فأحسنَ سياقتها
وإمرارها، فحببه أياماً وأخَّر عنه رسمه. وقال: تبسَّط في مجلسنا،
واسْحَنفر بحضرتنا، وترك توقيرنا وهيبتنا، حتى تشفّع في أمره أبو الحسن
الطبيب وغيره فعاد له على تشفّ.
وأنا أسوق حكاية الخليل حتى تكون فائدة في هذا الكلام الذي قد نشبنا فيه.
قال الخليل: دخلتُ على سليمان بن علي وهو والي البصرة فوجدته يُسقط في
كلامه، فجلستُ حتى انصرف الناس.
فقال: هل من حاجةٍ أبا عبد الررحمن؟ قلت: أكبر الحوائج.
قال: قل، فإن مسائلك مقضية، ووسائلك قوية.
قلت: أنت سليمان بن عليّ، وكان عليٌّ في العلم علياً، وكان عبد الله بن
العباس الحَبْرَ والبحر، وكان العباس بن عبد المطّلب إذا تكلّم أخذ سامعه
ما يأخذ النَّشوان على نقْر العيدان؛ وأراك تُسقط في كلامك، وهذا لا يشبه
منصبك ومحْتِدك.
قال: فكأنما فُقئَ في وجهه الرمان خجلاً.
فقال: لن تسمعه بعدها، فاحتجب عن الناس برهةً، وأكبَّ على النظر، ثم أذن
للناس في مجلسٍ عام، فدخلتُ عليه في ثُمَّةٍ من الناس، فوجدته يُفصح حتى
خِلته مَعدَّ بن عدنان. فجلست حتى انصرف الناس.
فقال: كيف رأيت أبا عبد الرحمن.
قلت: رأيتُ كلّ ما سرّ في الأمير، وأنشدته:
لا يكون السَّرِيُّ مثلَ الزَّرِيِّ ... لاَ ولا ذو الذّكاءِ مثلَ
الغَبِيِّ
لا يكون الأَلدُّ ذو المِقْوَل المُرْ ... هَف عند الخِصَام مثل العَيِيِّ
قيمةُ المرءِ كلُّ ما يُحسِن المَرْ ... ءُ قضاءٌ من الإِمام عَليِّ
أَيُّ شيءٍ من اللّباس عَلى ذي السَّرْو أَبهَى من اللّسانِ السَّرِيِّ
يَنظم الحجة الشتيتة في السِّلْك من القول مثل نَظم الهديّ
وَتَرى اللَّحن في لسَان أَخي الهِمّة مثل الصَّدَا عَلى المشرفيّ
فاطلب النحو للقُرَان وللشعر مُقيماً والمسنَد المرْويِّ
والخطابُ البليغُ عند حِجاج الْ ... قوم يُزهَى بمثله في النَّدِىّ
كلُّ ذي الجهل بالفنون يُعادِي ... ها ويزري منها بغير الزَّرِيِّ
قال: وانصرفتُ. فشيّعني غلامه على كتفه بدرة فرددتها عليه، وكتبتُ إليه:
أبلِغ سليمانَ أَنّي عنه في سَعَةٍ ... وفي غِنىً غيرَ أَني لَستُ ذَا مالٍ
سَخَّى بنفْسِيَ أَنّي لا أَرَى أَحداً ... يَموتُ هَزلاً ولا يَبْقَى على
حالِ
والرِّزْقُ عن قَدَرٍ لاَ العَجْزُ يَدْفعُه ... ولا يَزِيدُك فيه حَولُ
محتَالِ
وقال يوماً: " فَعْلٌ وأَفعالٌ " قليل، وزعم أصحابنا النّحويون أنه ما جاء
إلاّ زند وأزناد، وفرخ وأفراخ، وفرد وأفراد.
فقلت: أنا أحفظ ثلاثين حرفاً كلها " فَعْلٌ وأَفعال " .
قال: هات يا مُدَّعي! فسردتُ الحروف ودلّلتُ على مواضعها من الكتب.
ثم قلتُ: وليس للنّحويّ أن يجزم مثل هذا الحكم إلا بعد التبحّر والسَّماع
الواسع، وليس للتقليد وجهٌ إذا كانت الرواية شائعة، والقياس مطّرداً، وهذا
كقولهم: فَعيلٌ على عشرة أوجُه، وقد وجدته أنا على أكثر من عشرين وجهاً،
وما انتهيتُ في التَّتبع إلى أقصاه.
فقال: خروجك من دعواك في فعلٍ يدلنا على قيامك بالحجّة في فعيل،
ولكننا لا نأذن في اقتصاصك، ولا نهبُ آذاننا لكلامك، ولم يَفِ ما أتيتَ به
يجُرأتك في مجلسنا وتبسّطك بحضرتنا.
وسألني عن أبي حامد المرورُّوذِي. فوصفتُ له نباهته وتقدّمه وحفظه وبيانه.
فقال: ما تحفظ عنه؟ قلت: أشياء مختلفة، فإنه أقام عندنا ببغداذ في آخر
أيامه سنتين، ولقد رأيته في مجلس أبي الفرج محمد بن العباس في أيام
وزارته، بعد أبي الفضل العباس بن الحسين، وهو يتدفّق بالكلام مع ابن
طَرارَة.
فلما انتهى قال له أبو الحسن إسحاق الطبري: ارسُم لنا كلاماً خفيفاً في
الدّليل، والحُجّة، والبُرهان، والبيان، والقِياس، والعِلّة، والحُكم،
والاسم، والفِعل، والحَرف، والنَّصّ، والظاهر، والباطِن، والتأْويل،
والتفسير، والفحْوَى، والاستحسان، والتّقليد، والاقتداء، والإجماع،
والأَصل، والفَرْع، والوُجُوب، والجواز.
فاندفع فقال: الدّليل: ما سلكَكَ إلى المطلوب.
والحجّة: ما وثَقك من نفسك.
والبيان: ما انكشف به الملْتَمس.
والقياس: ما أعارك شِبهه من غيره، أو استعار شبه غيره من نفسه.
والعلّةُ: ما اقتضى أبداً حكماً باللّزوم.
والحكم: ما وجَب بالعلّة.
والاسم: ما صحّت به الإشارة إلى مُشارٍ إليه.
والفِعل: ما شاعَ في الزّمان.
والحرف: ما ائتلف به اللفظ.
والنّص: ما أغنى بنفسه لاستقلاله.
والظاهر: ما سبق إلى النّفس بلا جالب.
والباطن: ما غِيضَ عليه بالتّفسير.
والتأويل: الجهة المتباعدة عن المراد، ومع ذلك فهي مشمولة تارةً بالقصد،
وتارةً بغير القصد.
والفَحْوى: الجهة القريبة.
والتفسير: عبارة عن عبارة على طريق الخلافة.
والاستحسان: القول الأَوْلَى والأشبه في ظاهر الحال.
والتقليد: قبول بلا بيان.
والاقتداء: سلوك مع عالم سالف.
والإجماع: اتّفاق الآراء الكثيرة.
والأصل: ما لم ينظر إلى ما قبله، لأنه بنفسه قبل غيره.
والفرعُ: ما انشعب عن الأول والوجوب: ما لم يَسَع الإضراب عنه.
والجواز: ما وقف بين الواجب وبين غير الواجب.
وكاد لا يسكت.
فقال له أبو الفرج: ما كان أبو محمد المهلبي يُثني عليك جُزافاً، ولا يشغف
بك على طريق الهوى.
فقال لي: كيف حفظت هذا؟ قلت: كنّا جماعةً نتعاون على ذلك، ونرسم في ألواح.
فقال لي: إني لشديد الحَسرة على فوْت لقائه، ومما يزيدني عجباً به أنه كان
على مذهب أصحابنا، ولو نصر في الأحكام مذهب أبي حنيفة لكان قدوة لأهل
زمانه.
وقال له بعض الغرباء: إذا قلت عشي الرجل كما تقول: عمي الرجل، وتقول:
يعشَى كما تقول يعمى، وقلت أعشى كما تقول: أعمى، فهلاّ قلت: امرأة عشْياء
كما قلت عَمياء، ولك مع ذلك شفةٌ لَمْيَاء وفاه ظَمْياء؟ قال: فهكذا أقول.
قال له: قد خالفت العلماء، لأنهم نُّصوا عَشْواء كما قالوا: ناقةٌ عشواء.
فقال: في هذا نظر.
وأخطأ. وأي نظر في المسموع؟ وحدثني محمد بن المُرزبان قال: كنا بين يديه
ليلة فنعس، وأخذ إنسان يقرأ " والصَّافات " ، فاتّفق أن بعض هؤلاء الأجلاف
من أهل ما وراء النهر نعس أيضاً، وضرط ضرطةً منكرة، فانتبه وقال: يا
أصحابنا نمنا على " الصّافّات " ، وانتبهنا على " المُرْسَلات " .
هذا من ملاحاته.
وحدثني أيضاً قال: انفلتت ليلة أُخرى ضرطةٌ من بعض الحاضرين، وهو في
الجدل، فقال على حدَّته وجنونه: " كانت بَيْعةَ أبي بَكر " ، خُذوا فيما
أنتم فيه، يعني " كانت فَلتةً " لأنه قيل في بيعة أبي بكر " كانت فَلْتة "
.
أَ فهذا من المجون المستطاب؟ أو من جنس ما يجب أن يكون مَحكياً عن الرؤساء
الدَّيّانين والكُبراء المستبصرين، والذين يدّعون لأنفسهم الفضل والمروة
والديانة، واحتقار الناس؟ وقال له ابن ثابت الحوي يوماً: أنا آكل التّمر
على أنه كان مرة رُطباً، يتملّح معه، أي أميلُ إلى الحدث وإن بقل وجهه،
لأنه قد كان مرةً أمرَد.
فقال له: فكُل الخَرا على أنه مرةً كان هَريسةً.
وسمعته يُنشد في الشاعر الملقّب بالمشوق:
ودَيُّوثٍ يقال له المَشُوق ... لَه من عِرسه كَسْبٌ وسوقُ
فكَم خيْرٍ يُساق إِليهِ منها ... وكم أيرِ إِلى حِرِها يَسُوقُ
وكان يُنشد في شيخ كاتب من أهل جُرجَان:
جزِعتُ من أَمرٍ فظيع قد حَدثْ
ابن تَميم وهْو شيخٌ لا حَدَثْ
قَدْ حبَسَ الأَصلَعَ في بيتِ الحدَث
ورأيتُ شيخاً قدِم مع الحاجّ من خُراسان يُعرف بالخشوعي، من الكرَّامية
أصحاب البرانس، حضر مجلسه وناظره في مسألة الجسم، وكان يقول، وهو مذهب
هشام بن الحكم في التكلمين المتقدّمين: لما كان مُثبتاً بالعقل دون غيره،
وكنتُ لا أُثبِتُ بالعقل، إلا مَعقولاً، كما لا أُثبتُ بالسَّمعِ إلاّ
مسموعاً، وكما لا أُثبتُ بالبصر إلا مُبصَراً؛ وكان إثباتُ العقل لمن هو
غير جسمٍ في المُشاهدة غير معقول، وجب أن يكون جسماً لأنه قد كان دخل في
قسمة المعقول؛ وإن بطل أن يكون جسماً بطل أن يكون معقولاً، وقد ثبت أنه
معقول؛ فإذاً قد ثبت أنه جِسم.
فقال ابن عباد: هاتوا مسألة أخرى، فسماع كلام الحُكْل أرجع بالفائدة من
هذا، وأخذَ في مسألة أخرى.
وحكى قوم منهم أبو طاهر الأنماطي والقطّان أنه قد شُدِه ولم يحضره في
الحال شيء، وكان الخَصْم أَلدَّ ذا سلاطةٍ قليل الاكتراث، حضر غير طائع،
وتكلم غير متَروّع.
وعاد هذا الشيخ في مجلس آخر، فقال له: أتقول إن الله جسم؟ قال: نعم.
قال: فإذا كان جسماً جاز أن يكون فوقه شيءٌ أو تحته شيء، أو عن يمينه شيء،
أو عن يساره شيء.
قال: نعم.
قال: فما تُنكر أن يكون معبودك الآن في هذا الصّندوق؟ فخمد الخُراساني
خمدةً م اشتعل فقال: أَ ليس عندك أن الله متكلم بكلامٍ يفعله في الأحوال
المختلفة؟ فقال: بلى.
قال: فما تُنكر لأن يكون هذا الحمار يُنغط، فيُحلُّ الله كلامه في
جُرذانِه، فيقول: أنا ربكم الأعلى، وتسمع ذلك منه.
فانخزل ابن عبّاد وقال: خذوا في غير هذا.
والسخفُ والجُرأة وسوء الأدب وإطلاق اللّسان بما لا يجوز دِيناً ومروّة
غالبة على أصحاب الكلام؛ والتُّقى والرَّهبة والروع بعيدةٌ من هذه الطبقة.
وحكى يوماً في نوادره الفاترة ما يدلّ على قلّة دين القوم وسوء استبصارهم
وشدّة استهانتهم بما يقولونه مُحقّين ومُبطلين، وأن الدَّيدن هو الهذيان
والرَّقاعة والتعصُّب والإيهام، وليس لوجه الله في ذلك شيء، لا فيما
يجدّون به، ولا فيما يهزلون فيه، لا حشمة ولا تقوى، ولا مُراقبة ولا
بُقْيا؛ قد جعلوا الله عُرضةً للخصومات بالوساوس، ودينه مِنديلاً لكل يدٍ.
سأل ملحِد موحِّداً فقال: ما الدليل على أن للعالم صانعاً؟ فقال: الدليل
على ذلك شِعرة أمِّك، لأنها كلما نتفتها بالدِّبْق نبتت؛ فلو لم يكن هناك
مُنبت لما نبتت.
فقال الملحد: هذا ينقلب عليك لأنه يقال لك: الدليل على أن العالم ليس له
صانع نواةُ أمك، لأنها إذا قُطعت مرةً لم تنبتُ بعد ذلك.
وحكى يوماً آخر فقال: اجتمع رجلان؛ أحدهما يقول بقول هِشام، والآخر يقول
بقول الجَوالِقيّ.
فقال صاحب الجوالقي لصاحب هشام: صِف لي ربّك الذي تعبُده. فوصفه، فقال: هو
جِسم ولكن لا يد له ولا جارحة ولا آلة.
فقال له صاحب الجوالقيّ: أيسرُّك أن يكون لك بهذه الصِّفة ابن؟ قال: لا.
قال: أَ فما تستحي أن تصف ربّك بصفةٍ لا ترضاها لولدك؟ ثم قال صاحب هشام:
قد سمعت قولنا، فصف لي أنت ربّك. فوصف فيما وصف: أنه جَعْد قطِطٌ في أتَمّ
تمامٍ وأحسن حُسن وأَحلى صورة وأَعدَل هيئة وأجمَل شارة.
فقال له صاحب هشام: أَ فيسرُّك أن تكون لك جارية بهذه الصّفة تطؤها؟ قال:
نعم.
قال: أَ فما تستحي من عبادة من تحب مُباضعته؟ وذلك أن من أحبَّ مباضعة
مثله فقد أوقع عليه الشَّهوة، تعالى الله عن هذه السخافات والجهالات، وإن
قوماً يلهجون بهذا وأشباهه لَغي بعد من الهُدى والنُّهى.
وسمعته يسبُّ أصحاب الهندسة ويقول: جاءني بعض هؤلاء الحمْقى ورغَّبني في
الهندسة، فابتدأ، فأثبت خمسةً وعشرين، وخطّ خطّاً، ووضع شكلاً، وطوّل وزعم
أنه يعمل برهاناً على ذلك. فقلت له: إني كنتُ أعرف أن خمسة في خمسة خمسةٌ
وعشرون ضرورة، وقد شككت الآن، فأنا مجتهد حتى أعلمه بالاستدلال. وهذا هو
الخَسار والدّمار.
ولو كان له سهْم يسير من العقل ما باح على نفسه بهذا القول، ولو سُمع من
غيره لوجب إنكاره، ولو حقق قول القائل: من جهل شيئاً عاداه. أَ تُراه ما
سمع كلام ابن ثوابه في مثل هذا، وكيف نُسب فيه إلى الرّقاعة، وكيف رحِمه
أهل الحِكمة، وكيف هزئ به قومٌ وجدوا طريقاً إلى ذلك.
وأنا أحكي لك في هذا المكان الكلام وإن تنفّست الرسالة، لتعلم أن
من شاء حَمَّق نفسه، وأن الله إذا شاء خذل عبده وأشْمَت به أعاديه.
حدثنا أبو بكر الصَّيمريُّ قال: حدثنا ابن سمكة قال: حدثنا ابن مُحارب
قال: سمعتُ أحمد بن الطيّب يقول: إن صديقاً لابن ثوابة الكاتب أبي العباس
يُكنّى أبا عبيدة قال له ذات يوم: إنك رجلٌ - بحمد الله ومنّه - ذو أدب
وفَصاحة وبراعة وبلاغة؛ فلو أكملت فضائلك بأن تُضيف إليها معرفة البُرهان
القياسيّ، وعلم الأشكال الهندسية الدّالة على حقائق الأشياء، وقرأتَ كتاب
" أُقليدس " وتدبّرته؟ فقال له ابن ثوابة: وما " أُقلِيدس " ؟ قال له: رجل
من علماء الروم يُسمى بهذا الاسم، وضع كتاباً فيه أشكال كثيرة مختلفة تدل
على حقائق الأشياء المعلومة والمغيّبة، يَشحَذ الذهن ويدقّق الفهم،
ويُلطّف المعرفة، ويصفّي الحاسّة، ويثبت الرَّوية؛ ومنه انفتح الخط وعُرفت
مقادير حروف المعجم.
فقال له أبو العباس ابن ثوابة: وكيف ذاك؟ قال: لا تعلم هو حتى تشاهد
الأشكال وتُعاين البرهان.
قال له: فافعل ما بَدَا لك. فأتاه برجل يقال له قُويري مشهور مقدّم، ولم
يعد إليه بعد ذلك.
قال أحمد بن الطيّب: فاستطرفت ذلك وعجِبتُ منه، وسألت المُخبر عن انصراف
قُويري أي شيء كان سببه؟ فأجابني بأن لا أعلم، فكتبت إلى ابن ثوابة رقعة
نُسْخَتها: بسم الله الرحمن الرحيم.
اتّصل بي - جعلني الله فِداك - أن رجلاً من إخوانك أشار عليك بتكميل
فضائلك وتقويتها بمعرفة شيءٍ من القياس البُرهاني، وطمأنينتك إليه، وأنك
أصغيت إلى قوله وأذنتَ له، وأنه أحضرك رجلاً كان غايةً في سوء الأدب،
معْدِناً من معادن الكُفْر، وإماماً من أئمة الشّرك؛ لاستفزازك واستغوائك،
يُخادعك في عقلك الرَّصين، ويُنازلك في ثقافة فهمك المتين، فأبى الله
العزيز إلاّ جميل عوائده الحسنة قِبَلك، ومِننه السَّوابق لدي، وفضله
الدائم عندك، بأن أتى على قواعد بُرهانه من ذروته، وحطّ عوالي أركانه من
أقصى معاقد أُسِّه، فأحببتُ استعلام ذلك على كنهه من جهتك، ليكون شُكري لك
على ما كان منك حسب لومي لصاحبك على ما كان منه، ولأَتَلافَى الفارط في
ذلك بتدبّر أُسُسِه إن شاء الله.
قال: فأجابني ابن ثوابة برُقعة نُسختُها: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلت
رُقعتك - أعزّك الله - وفهمتُ فحواها، وتدبّرتُ مُضمَّنها، والخبرُ كما
اتّصل بك، والأمر كما بلغك. وقد لخصته وبيَّنته حتى كأنك معنا وشاهِدُنا.
فأول ما أقول: الحمد لله وليّ النِّعم، والمتوحِّد بالقسم، إليه يُردّ
علمُ السّاعة وإليه المصير؛ وإياه أسأل إيزاعَ الشكر على ذلك وعلى ما
منَحنا من وُدّك وإتمامه بيننا بمنّه.
ومما أحببتُ إعلامك وتعريفكه مما تأدّى إليك، أن أبا عُبيدة - عليه لعنةُ
الله تَتْرى - بنحسِه ودسّه ودحْسِه اغتالني ليكلم ديني من حيث لا أعلم،
وينقُلني عما أعتقده وأراه وأُضمره من الإيمان بالله عز وجلّ ورسوله صلى
الله عليه، فوطّدَ لي الزّندقة بتزْيِينه الهندسة، وأنه يأتيني برجل
يُفيدني علماً شريفاً تكمل به فضائلي - فيما زعم - فقلتُ: عسى أن أُفيد به
براعةً في صناعة، أو كمالاً في مُروَّةٍ، أو نُسْكاً في دين، أو فخاراً
عند الأَكفاء. فأجبته بأن هلُمّ به! فأتاني بشيخ ديرانيّ شاخص النظر،
منتشر عصب البصر، طويل مشذّب، محزوم الوسط، متزمّل في مسكه، فاستعذتُ
بالرحمن إذ نزغني الشيطان، ومجلسي قد غصَّ بالأشراف من كل الأطراف، كلهم
يرمُقه ويتشوّف إلى رفْعي مجلسه وإدنائِه وتقريبه، ويعظّمونه ويحيُّونه،
والله محيط بالكافرين.
فأخذ مجلسه، ولَوَى أشداقه، وفتح أوساقه، فتبيّنت في مُشاهدته النِّفاق،
وفي ألفاظه الشِّقاق.
فقلتُ له: بلغني أن عندك معرفة بالهندسة، وعلماً واصلاً إلى فضل يفيد
الناظر فيه حكمةً وتقدُّماً في كل صنعة؛ فهلُمَّ أفِدنا شيئاً منها عسى أن
يكون عوناً لنا على دينٍ أو دنيا، وزَيْناً في مروّة أو مُفاخرة لدى
الأكفاء، ومُفيداً نسكاً وزُهداً، (فذَلِكَ هُوِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)،
(فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ)،
(وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ).
قال: فأحضِرني دواةً وقرطاساً، فأحضرتُهما، فأخذ القلم فنكَت به
نكتةً نقط منها نقطة، فَخيُّلها بصري ولحظها طرفي كأصغر من حبّة الذّر،
فزمزم عليها بوسواسه، وتلا عليها من مُحكم أسفار أباطيله، ثم أعلن عليها
جاهراً بإفكه؛ وأقبل عليّ فقال: أيها الرجل! إن هذه النقطة شيء ما لا جزء
له.
فقلت: أضلَلْتني وربِّ الكعبة! وما الشيء الذي لا جُزء له؟ فقال: كالبسيط.
فأذهلني وحيّرني، وكاد يأتي على حِلمي وعقل لولا أن هداني ربّي؛ لأنه
أتاني بلُغةٍ ما سمعتها والله من عربيّ ولا عجميّ، وقد أحطتُ علماً بلُغات
العرب، وقُمتُ بها واستثرتُها جاهداً واختبرتها عامداً، وصرت فيها إلى ما
لا أحسب أحداً يتقدّمني إلى المعرفة به، ولا يسبقني إلى دقيقة وجليله.
فقلت له: وما الشيء البسيط؟ فقال: كالله تعالى وكالنفس.
فقلت له: إنك من المُلحدين، أتضرب لله أمثالاً؟ والله تعالى يقول: (فَلاَ
تَضْرِبُوا للهِ الأَمْثَالَ إنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ
تَعْلَمُونَ).
لعَن الله مرشداً أرشدني إليك، ودالاً دلّني عليك، فما ساقك إليّ إلاّ
قضاء سوء ولا كسحك نحوي إلا الحَيْن، أعوذ بالله من الحين، وأبرأ إليه
منكم ومما تُلحدون، والله وليُّ المؤمنين (إِني بَريءِ مِمَّا
تُشْرِكُونَ)، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العليّ العظيم.
فلما سمع مقالتي كره استعاذتي فاستخفّه الغضب، فأقبل عليّ مستبسلاً فقال:
إني أرى فصاحة لسانك سبباً لعُجمة فَهمك، وتذَرُّعك بقولك آفةً من آفات
عقلك.
فلولا من حضر - والله - المجلس وإصغاؤهم إليه مستصوبين أباطيله، مُستحسنين
أكاذيبه، وما رأيت من استهوائه إياهم بخُدعة، وما تبيّنتُ من تَوازُرهم
لأمرت بسلّ لسانِهِ اللُّكع الألكن.
وأمرتُ بإخراجه إلى حَرّ نار الله وسقره وغضبه ولَعْنتِه.
فنظرتُ إلى أمارات الغضب في وجوه الحاضرين، فقلتُ: ما غضبُكم لنصرانيّ
يشرك بالله ويتّخذ له من دونه الأنداد، ويُعلن بالإلحاد؟ ولولا مكانكم
لنَهَكتُه عقوبةً.
فقال لي رجل منهم: إنه أنسانٌ حكيم، فغاظني قوله.
فقلت: لعن الله حكمةً مشوبةً بكُفر.
فقال لي آخر: إن عندي مُسلماً يتقدّم أهل هذا العِلم.
فرجوت - مع ذكرهِ الإسلام - خيراً فقلت: ائتني به، فأتاني برجل قصير دحداح
مجدُورٍ آدم أخفش العينين أجلح أفطس سيِّئ النّظر قبيح الزيّ، فسلّم
فرددتُ عليه السلام، ورفعت مجلسه وأكرمته، وقلت له: ما اسمك؟ فقال: أُعرف
بكنيةٍ قد غلبت عليّ.
فقلتُ: أبو مَن؟ فقال: أبو يحيى.
فتفاءلتُ بملَك الموت عليه السلام، وقلتُ: اللهم إني أعوذ بك من الهندسة،
فاكفني اللهمَّ شرَّها، فإنه لا يصرف السوء إلا أنت، وقرأتُ " الحمد " ، و
" المعَوِّذَتَيْن " ، و " قل هو الله أحد " ثلاثاً، وقلتُ له: إن صديقاً
لي جاءني بنصرانيٍّ يتّخذ الأنداد، ويدّعي أن لله الأولاد ليُغويني
ويستفزّني (ولَوْلاَ رَحْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ المُحْضَرينَ)، فصرفته
أقبح صرف، ثم ذُكِرتَ لي فرجوت - بذكر إسلامك - خيراً.
فهلُمَّ أفِدنا شيئاً من هندستك، وأقبسنا من طرائف حكمتك ما يكون لنا
سبباً إلى رحمة الله ووسيلة إلى غُفرانه، فإنها أربح تجارة وأعودُ بضاعة.
فقال: أحضرني دواةً وقرطاساً.
فقلت: أَ تدعو بالدَّواة والقرطاس، وقد بُليتُ منهما ببليّة كَلْمُها لا
يندَمِل عن سُوَيداءِ قلبي؟ قال: وكيف كان ذلك؟ قلت له: إن النصراني نقط
لي نقطةً كأصغر من سمّ الخياط، وقال لي: إنها معقولة كربّك الأعلى، فوالله
ما عدا فرعون في إفكه وكُفره.
فقال لي: فإني أُعفيك، لعنَ الله قُويري وما كان يصنع بالنُّقطة؟ وهل بلغت
أنت أن تعرف النقطة؟ فقلت: استجهلني وربّ الكعبة، وأنا قد أخذت بأزمّة
الكتابة، ونهضت بأعبائها، واستقللت بثقلها يقول لي، لا تعرف فحوى
النُّقطة، فنازعتني نفسي في معاجلته بغليظ العُقوبة، ثم استعطفني الحِلم
إلى الأخذ بالفضل.
ودعا بغُلامه وقال: ائتني بالتّخت، فوالله ما رأيت مخلوقاً بأسرع
إحضاراً له من ذلك الغلام، فأتاه، فتخيَلت به هيئةً منكرة ولم أدر ما هو،
وجعلت أُصوّب الفكر فيه تارةً وأًصعّد أُخرى، وأجيل الرأي ملياً وأُطرق
طويلاً، لا أعلم أي شيءٍ هو، أَ صندوق هو؟ فإذا ليس بصندوق، أَ تخت هو؟
فإذا ليس بتخت، فتخيّلته كتابوت لحد. فقلت: لحدُ الملحد يُلحد به وبالنّاس
عن الحقّ. ثم أخرج من كُمّه مِيلاً عظيماً فظننته متطبّباً وإنه لمن شرار
المتطبّبين.
فقلت له: إن أمرَك لعَجَب كله ولم أرَ في أميال المتطبِّبين كميلك، أتقفأُ
به الأعين؟ فقال: لستُ متطبِّباً ولكني أخطُ به الهندسة على هذا التخت.
فقلت له: إنك وإن كنت مبايناً للنصراني في دينه، إنك لمؤازره في كُفره، أَ
تخطُّ على تختٍ بميلك لِتعدل بي عن وضح الفجر إلى غسق الليل؟ وتميل بي إلى
الكذب باللَّوح المحفوظ وكاتبيه الكرام؟ أَ إِيايَ تستهوي؟ أم حَسبتني
ممّن يهتزّ لمكايدكم؟ فقال: لستُ أذكر لك لوحاً محفوظاً ولا مُضيعاً، ولا
كاتباً كريماً ولا لئيماً، ولكني أخُطُّ به الهندسة، وأُقيم عليها البرهان
بالقياس والفلسفة.
وأخذ يخطّ وقلبي مُروَّع يجب وَجيباً.
فقال لي غير مُستعظِمٍ: إن هذا الخط طول بلا عرض، فذكرت صراط ربّي
المستقيم، وقلتُ له: قاتلك الله! أَ تدري ما تقول؟ تعالى صراط ربّي عن
تخطيطك وتشبيهك وتبديلك وتحريفك وتضليلك، إنه لصراطٌ مستقيم، وإنه لأَحدُّ
من السيف الباتر، والحُسام القاطع، وأدقُّ من الشَّعر، وأطول مما تمسحون،
وأبعَد مما تذرعون، ومداه بعيد، وهولَهُ شديد؛ أَ تطمع أن تُزحزِحَني عن
صراط ربي أم حسبتني غُمْراً غبياً لا أعلم ما في باطن ألفاظك ومكنون
معانيك؟ والله ما خططت الخطّ وأخبرت أنه طولٌ بلا عرض إلا حيلةً بالصراط
المستقيم لتُزِلَّ قدمي عنه، وأن تُرديني في نار جهنّم.
أعوذ بالله وأبرأ إليه من الهندسة، ومما تدلُّ عليه وترشد إليه، وإني
بريءٌ من المهندسين وما يُعلنون ويُسرُّون، ومما به يعملون؛ ولَبئس ما
سوّلت لك نفسك أن تكون من خزنتها بل من وقودها، وإنّ لك فيها لأنكالاً
وسلاسل وأغلالا، (وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وعَذَاباً أَليماً). قُم إلى
لعنة الله وغضبه! فأخذ يتكلم. فقلت: سُدّوا فاه مخافة أن يبدر منه مثل ما
بدّر من المضلِّل الأول، وأمرتُ بسحبه فسُحب إلى أليم عذاب الله ونارٍ
(وَقُودُها النَّاسُ والحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ
لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ).
ثم أخذتُ قرطاساً وكتبتُ بيدي يميناً آليتُ فيه بكل عهدٍ مُؤكَّد، وعقدٍ
مُردَّد، ويمينٍ ليست لها كفّارة - أن لا أنظر في الهندسة أبدا، ولا
أطلبها، ولا أتعلّمها من أحدٍ سرّاً ولا جهراً، ولا على وجهٍ من الوجوه،
ولا بسببٍ من الأسباب؛ وأكَّدتُ بمثل ذلك على عقبي وعلى أعقاب أعقابهم: أن
لا ينظروا فيها ولا يتعلّموها ما قامت السموات والأرض، إلى أن تقوم الساعة
(لِميقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ).
فهذا بيانُ ما سألت - أعزّك الله - عنه مما دُفعتُ إليه وامتٌحنت به،
ولتعلم ما كان مني، ولولا وَعكةٌ أنا في عَقابيلها لحضرتك مُشافِها،
وأخذتُ بحظّي المُتمنّي من الأُنس بك، والاستراحة إليك؛ فمَهِّد على ذلك
عُذري، فإنّك غير مُباين لفكري، والسّلام.
رسالة أبي العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن ثوابة إلى أبي العباس أحمد بن
الطيّب هذه، فيها مُعتبر واسع، وإشراف على عقلٍ مدخول، وهي شقيقة قول ابن
عبّاد في الحكاية التي جرت قبل هذه؛ وليس ينبغي أن يُغتَرّ بالإنسان إذا
كان فصيحَ العبارة، كثير التّشقيق، مديدَ النّفس، قادراً على السّجع، سهل
الارتجال؛ فقد يأتلف هذا كلُّه والعقل ناقص، وقد يُفقَد هذا كلّه والعقلُ
راجح.
وقلتُ لأبي سعيد السيرافيّ شيخ الدُّنيا: قال أبو زيدك يقال إنه لكثير
فضيض الكلام، أَ يرادُ بهذا مدح المذكور أم الزِّراية عليه؟ فقال لي: هو
إلى الزّراية أقرب؛ لأن الفَضّ كسرٌ، ومنه: فضضت ختم الكتاب، ومنه: ضَرَبه
فصار فُضاضا؛ والصّحيح خير من المكسور، وكأنه يراد بهذا أنه يرمي بهذا
بالكلام مكسَّراً غير صحيح.
وإنما أتيت بهذا لأني سألت مرةً أبا السلم عن ابن عبّاد، فقال: إنه لكثير
فضيض الكلام، ثم مرَّ بي لأبي زيد.
وكان بن عبّاد يقول كثيراً: ما مدحني شاعر بأوجز وأملح من أبياتٍ
وافَتْني من شاعرٍ ينتسب لسجِستان؛ فإنها تدلّ على قدرة صاحبها وغزارة
قائلها وحُسن تصرّفه فيها، وهي:
يا مَن أعادَ رَميمَ الملك مَنشورا ... وضَمّ بالرأيّ أمراً كان منشورا
أنتَ الوزيرُ وإِن لم تُؤتَ منشورا ... والأَمْر بَعدك إن لم يُؤتمن شُورَى
وقال ابن نباتة والخالع وابن الجَلَبات: ليس في هذه الأبيات ما وجب له هذا
الإعجاب كلّه، ولكن الرجل طريف المرأى والمخبر، عجيب المبشر والمنظر؛
مَداره على الهوى، كيفما سنَح له جنح إليه، وأينما برّح به طُرح عليه.
وكان ابنُ عبّاد إذا تكلّم في مسألة ثم رأى في خصمه فتوراً نفش لحيته
بأصابع يده وعبث بها، وفتل رأسه ولوى عُنقه، وشنّج أنفه، وعوّج شِدقه،
وقال منشداً:
إِذا المشكِلاتُ تصَدَّين لي ... كشَفتُ حقائقها بالنظَرْ
وإِن برَزَت في مَخِيل الصَّوا ... بِ عَمياءِ لا تَجْتَليها الفِكَرْ
مُقنَّعةً بخَفِيّ الشكُّو ... كِ وضَعتُ عليها حُسَام النظرْ
لساناً كشِقْشِقَة الأَرحِبيّ أو كالحُسام اليَماني الذّكَرْ
ولستُ بذِي وقْفَةٍ في الرجا ... لِ أُسائل هذا وذا ما الخَبَرْ
ولكنَّني مِدْرَهُ الأَصغَريْ ... ن أَقيسُ بما قَدْ مَضَى ما غَبرْ
وكان لا يبعثه على هذا النمط إلا الذَّهاب بنفسه، والتّيه الذي يحول بينه
وبين عقله؛ والعجيب أنه كان يعيب غيره بجزءٍ من هذا الباب لا يتجزّأ،
ويقول: انظروا إلى تيههِ وصَلَفه ومدحه لنفسه واستبداده برأيه - وعلى هذا،
حتّى إذا صار إلى نفسه وحديثه وخوّاص أمره جهل وذهل، وخرج في مُسْك من لم
يسمع بشيءٍ من ذلك، ولم يفطن له، ولم يأبه لقبيحه، ولم يأنف من شنيعه.
وهذا من الأسرار في الأخلاق، ولهذا طال كلامُ الأوّلين في الأخلاق، وجاءت
الشّريعة واللُّغة واضعة كلاً في موضعها، وناعتةً لمختارها ومرذُولها،
وباعثةً على حَسَنها وجميلها، وداعيةً إلى رفض قبيحها ومُنكرها.
والكلام في هذا طويل الذَّيل ميّاس، وما أحسن ما قال الشاعر:
لا تَلُم المرءَ عَلَى فعلِهِ ... وأنتَ مَنسوبٌ إلى مِثلِهِ
من ذَمَّ شيئاً وأتَى مِثلَهُ ... فإنما يُزْرِي على عقلِهِ
والبيت السائر:
لا تَنْهَ عن خلُقٍ وتأْتي مثلَهعارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ
فهذا هذا.
حدثني العتّابيّ قال: قال قومٌ من أهل أصفهان لابن عبّاد: لو كان القرآن
مخلوقاً لجاز أن يموت، ولو مات القرآن في آخر شعبان بماذا كنّا نصلّي
التّراويح في رمضان؟ فقال: لو مات القرآن كان رمضان أيضاً يموت، ويقول: لا
حياة بعدك، ولا نُصلَي التراويح، ونستريح.
وسأله الدّامغاني يوماً عن قوله عزّ وجلّ: (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ،
وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ)، أَ تقول أن يوسف
همّ بالمعصية؟ فقال: الكلام معطوف بعضه على بعض بالتّقديم والتأخير، فكأنه
قال: لولا أن رأى بُرهان ربّه لقد كان يَهُمُّ بها، ولكنه لم يُهمّ، وهذا
كقول القائل: إني غَرقت لولا أنه خلصني فلان.
فحدّثتُ بهذه الجملة ابن المراغي ببغداد، فقال: لو سكت عن هذا كان أحسن
به، هذا تقدير لاعبٍ بكتاب الله، لا يحلّ نظم الكلام على تحريفه؛ لأن ذلك
جرأة؛ أما سمعت الله يقول: (لاَ تقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ
وَرَسُولِهِ)؟ إنما المراد به على سجية الكلام؛ ولقد همّت به همّها
اللائق، وهمّ بها هَمَّ البشر الذي لا براءة له من همّة إلا بتوفيق الله،
والبرهان كان ذلك التوفيق.
وما في الهمّ؟ الله أكرم من أن يؤاخذ به، وإنما ذُكر ذلك ليعلم أن النبي
صلى الله عليه في نُبوّته غير مُكتفٍ بها دون أن يكنفه الله بعصمته،
ويتغمّده برحمته.
وسئل ابن عباد يوماً عن قوله عزّ وجلّ: (يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ
مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرانِ، فَبأَيّ آلاَءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبانِ)، فقيل: كيف يجوز أن يُعدَّ هذا في الآلاء والنِّعم، وهو
إحراقٌ بالنّار، ولا ألم بعده، ولا عذاب فوقه؟
فقال: أقول ما قال شيخنا أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصريّ
رحمه الله، فإنه قال: إن الله جعل جهنّم سوطاً ساق به عباده إلى الجنّة؛
واللّفظ عن الحسن - على ما عُنينا بجمع كلامه عن الرُّواة - : " إنَّ الله
خَلق جهنّم لِيحوُش بها الخَلق إلى طاعته " .
فقال أصحابُنا: فزَعُه إلى الحكاية عن الحسن حاكم بأنه مُفلس، وقد قال
العلماء في ذلك، وإنما قول الحسن ترقيق، وكلام يدخل في الوعظ ولو حُقّق
لقلق.
وسأله الدّامغاني يوماً عن قوله تعالى: (وَلَمّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى
الغَضَبُ) أي موضع هذا السكوت، والسّكوت ضد الكلام كما أن السكون ضد
الحركة؟ فما أحلى ولا أمرّ، وتغافل إما كِبراً وإما جهلاً.
وسمعتُ ابن بابويه يقول في هذا؟ هو مما حُرِّف لأنه نزل: (وَلَمَّا سَكَن
عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ) بالنون.
فقلت له: وما درك المحرَّف في هذا؟ فقال: هو ما قلتُ لك، وقد صحّ عندنا
ذلك عن الصّادق.
فأمسكتُ عنه؛ والجوابُ أبين من ذلك.
وقال يوماً الحصيري: أيها الصاحب! ما أقول لخصمي إذا قال لي: حدُّ الظّلم
وضع الشيء في غير موضعه؟ قال: قل له يجب على هذا إذا أخذ الرجل عمامته
المكوَّرة فوضعها على رُكبته أن يكون ظالماً.
قال أبو سُليمان: أخطأَ، لأن العمامة قد توضع على الركبة لغرضٍ صحيح
وحاجةٍ بادية، في وقتٍ مُقتضٍ لذلك، وزمانٍ يليق به ذلك، ويكون حسناً
عدلاً، ويكون في مكانها؛ والرأس أيضاً جُعل مكانها لغرض معروف، والأغراض
تختلف وتأتلف.
وقيل له يوماً: ما أنكرت أن يكون الرِّزق ما يأكله المرزوق دون غيره؟
فقال: على هذا لو رزقك الله خُفّاً لكنت تأكله.
حكيت هذا لأبي سليمان فصرّف القول في الرّزق وفي أقسامه وعلله وأسبابه
وغرائبه؛ وقد أخَّرته لمكان آخر، فإن هذا الكتاب يضيق عنه، ويخرج عن الأمر
المُتحرّى به.
وقال له أبو عاصم البصري يوماً: أَ ليس المتكبّر هو الذي يتعظّم زائداً
على ما يستحقّه ويحسن به، ومن أجل ذلك ذَمّوه بهذا الاسم إذا أطلقوه؟
فقال: بلى! قال: فما معنى وصف الله نفسه بالتكبر؟ ونحن إنما نفينا عنه
التكبُّر لقُبحه عندنا وعند المعروف به بيننا، فلو ساغ أن يُنعت بالتكبّر
ساغ أن يُنعت بالتكذّب.
فاشتطّ وانتفخ وتربّد وجهه ودرّ وريده وكاد يزند، ثم تدفّق بكلام كثير ليس
من مسألة أبي عاصم في شيء، حفظت منه قوله: أحدهم لا يعرف اللغة على
طرائقها ودقائقها وحقائقها من ناحية مجازها وسعتها، ولا من ناحية سلامتها
وصحّتها؛ ولا يُفرّق بين ما يجوز على الله وبين ما لا يجوز على الله؛
ويقصد إلى المسائل المُشكلة، والمعاني المُعضلة، والأبواب الغامضة،
والألفاظ المتعارضة، فيسأل عنها، ويُعجب بها.
ليتك عرفت هذا بعد أن تعرف معنى قول العرب: " صابَت بقُر " ، وما المراد
بقولهم: " عَوْدٌ يُعلَّم العَنْج " ، وما معنى قولهم: " لكلّ جابِةٍ
جَوزةٌ ثم يُؤذَّن " ، ومَن جمَع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه،
ومتى توفي المَبْرمان، وما البديع، وما بديع البديع، وما المخترع، ومَن
صاحب البيت السائر:
وبي مثل الذي بك غير أَني ... أُلام عَلَى البكاءِ وتُعذَرينا
ولقد صدق الأعرابي في قوله: كُن كالضبّ الأعور يعرف قدره ولا يُفارق
جُحْره؛ وأصاب عمر في قوله: لا تحملوا النَّفس على المهجور فتتركوا
المفروض، ولا تتجنّبوا المأذون لكم فيه فتركبوا المنهيَّ عنه.
يحضُرنا قوم لهم دَفر كصُنان التيوس أعيا على المسك والغالية، يسألون عما
لا يعنيهم ولا يليق بقدرهم، ولو سألت واحداً منهم عن كُنية أعشى هَمْدان
أو عن دُعيمص الرّمل، وما ايم النموذج في كلام العرب، وكيف يُجمع العِجان،
وكيف يصرف الهِجان، وما الأقذُّ والمَريش، وما الخِبَاء والعريش، وما
المشوق والحريش، وما المشوف والخريش، وما الرَّثْيَة والفريش، وما الكصيصة
والقصيصة، والخرْبَصيصَة والهَلْبَسيسَة، وما الفرق بين: ما أنت أخانا
فنكرمَك، وبين ما أنت أخانا فنهينُك، الأول بالنصب والثاني بالرفع، ومَن
الذي يقول:
فأَرميها بجُلْمودٍ ... وترميني بجُلْمود
فأرميها وتَرميني ... وكل هالك مود
ولكن صدق عمرو بن عُبيد شيخنا وشيخ الإسلام، وشيخ " العدل
والتوحيد " حين قال: لن يكون العبد مستكملاً لاسم الولاية حتى يسمع الكلمة
العَوراء فيجعلها دُبُرَ أُذُنه.
هذا مع قوله: تقويم الجاهل بما ينكر أيسرُ من تعريفه ما يجهل، ولولا أن
عُذري في تقويمك وتأديبك وتهذيبك وتربيتك يغمُض على كثير ممن يسمع هذا
الحديث لسلخت شواتك، وكسرت على رأسك دواتك، وألزمتك دكانك وأداتك وأطعمتك
بولك وخِراتك. اذهب فأنتَ طليق الجهل والقلّة، عتيق الخيبة والذلة.
وكان إذا انتهى كلامه مع خصم يقول: النظر شِعاري، والجدل دِثاري، والحقّ
مَناري، والبيان مَداري، والله جاري.
وقال يوماً للحسين المتكلّم: أَ لي تقول هذا، والجَدَل رِدائي، ولنظَر
حِذائي، والعلم وطائي، والبلاغةُ غطائي، والذّهبُ والفضّة عَطَائي؟ وقال
يوماً لأبي صادق الطّبري: أنت يا أبا صادق خفيفُ الراس، شديد الإِفلاس،
إذا أبصرت النِّحار هذَيت بالوسواس، وصدَّعت رؤوس الناس، بالتَّمويه
والإلباس.
وسمعته يوماً يقول لابن شاذان: يا أبا الحسن، توقّ الرسَن، وانظر إلى
المسَنّ؛ فما أخوفني أن تُسن بالقبيح لا بالحسن.
فقال له: أيها الصاحب! كَرَم طبعك أمانٌ لي من بوائق سَجعك.
وقال يوماً لابن حمزة: والنظر من خَوَلي؛ هل هضبةٌ تُوفى على جَبَلي؟
فاحفظ نفسك، واعرف خصمك، وراجع فهمك، وجرِّب بختك.
وكانت له تعسات كثيرة،لكنها كانت تُدفن ولا تُذاع، رَهبةً ورغْبة.
قال يوماً: " اطَّلععليه " ، ولا يجوز " إليه " ، والمعنى يقتضي عليه لا
غير.
فقال له الضرير النحوي: فما نصنع بقوله عز وجل: (لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى
إِله مُوسَى)؟ فبرد.
ومن هذا الضرب قال يوماً: جنَّ عليه الليلُ، أي كنَّه الليل، ولا يجوز غير
هذا.
فقال له أبو عمران الحسنكي: هذا لعمري في الفصيح، وإياه ذكر ثعلب واختاره،
ولكن أين نحن من المرّار الفقعسيّ، وهو أفصح من عالم صاحب " الفصيح " ،
فإنه قال:
آليتُ لا أُخفِي إِذا الليلُ جَنَّني ... سَنَا النّارِ عن سارٍ ولا
مُتَنوِّرِ
فقال: يا أبا عمران! أنت جاهل بالعلم، ولذلك شوّه الله وجهك، ووكّل المقت
والإدبارَ بك.
وأنشد يوماً لشاعر:
إذا قلتُ لها: جُودِي لَنا ... خرجَت بالصَّمت من لاَ و نَعم
قلت: أصحابنا كذا يُنشدون، ويقال فيه تصحيف.
فقال: اسلح على أصحابك.
ولو كان سأل عن وجه التّصحيف لكان أشبه بالفضل وأخلَق بأخلاق الرؤساء.
وقيل له يوماً: ما القُرحان؟ قال: الذي لم يخرج به الجُدَري.
قيل: ولم قيل ذلك؟ قال: ليُسخن الله به عين السائل، ويُسخّم وجهه، ويسمل
عينه، وليُقلّ دينه، ويدُقَّ ظهره، ويسلّط عليه من يَسُدُّ دُبُرَه.
واستؤذن يوماً للورّاق الطرسوسي فقال: الطَّرُّ في لحيته، والسوس في
حِنطتِه، ما أصنع بطلعته؟ وتكلم يوماً الخطيب في قول الرجل: " لا مالَ له
قليلٌ ولا كثير، ولا مال له قليلاً ولا كثيراً " ، فلم يفهم عنه.
وقيل له: ما الفرق بين " با " و " تا " و " ثا " في مواضعها المخصوصة؟
فتحيّر. وكان السائل ابن المراغيّ.
وقيل له: لم جاز: إنّ زيداً منطلق وعمرو، ولم يجز: ليت زيداً منطلقٌ
وعمرو، والحرفان مُتضارعان في إيجاب النصب؟ فلم يكن عنده جواب.
ولقد سهرتُ معه ليلة في معرفة الفرق بين: " زيدٌ أفضلُ إِخوته وزيدٌ
أَفضَل الإِخوة " وجواز أحدهما وبُطلان الآخر، فكان كالحمار بلادة.
وقلت للحيلوهي: إنك تنال من عِرض هذا الرجل جدّا؟ فقال: قال النبي صلى
الله عليه: " لَيُّ الواجِد يُحِلُّ عِرضه وظهرَه " كما قال: " مَطلُ
الغَنِيّ ظُلم " .
قلت: إنما وَرد هذا في الواجب، كالدَّين والثَّمن وما أشبههما.
فقال: الأمل دَيْن، والكَرَم مطلوب، وما رأّسَ اللهُ أحداً إلا وفرض عليه
الإفضالَ والإحسان.
وقيل لعقيل بن عُلَّفة: لم تهجو قومك؟ فقال: إن الشاة إذا وردت الماء فلم
يُصفر لها لم تشرب، أي إذا لم يُحرِّضوا على المكارم لم يفعلوها.
قال: وأنا استحسن قول الفضل بن يحيى: ما حثّني أحد على الكرم كرجل أنشدني
بيتين وهما:
عُدْ لي بعادتك التي عوَّدتَنيروحِي فداؤُك يا أَبا العبّاسِ
إن الذَّخائر إن أَردتَ ذخيرةًمِمَّن يُقلّدها رقابُ الناس
قال: وأعجبُ من ذلك قول جرير فيما رواه الصُّولي: إذا مدحتم
فاختصروا، وإذا هجوتم فأطيلوا؛ فإن الناس لا يملُّون الشَّر.
ورأيته يوماً، وقد جَرَى وانقطع ظهره؛ فإنه قال: قولهم: " إنها لإبلٌ أم
شاءٌ " ، معناه: بل شاءٌ.
فقال له الحَنْسكي: فما تصنع بقوله عزّ وجل: (أَمِ اتَّخَذَ مَمَّا
يَخْلُقُ بَنَاتٍ؟) أَ تُراه أراد به: بل اتّخذ مما يخلق بناتٍ، وهذا كفر؟
فما دارَ لسانُه بشيءٍ على حدّته وكثرة هَذَيانه.
وحدثني العَبسي، وقد جَرى ذكر ابن عباد:
لقد أَتانَا حديث ما نكذّبه ... عن الرَّسول روَيناه بإِسنادِ
أن تطلُب الْخيرَ ممَّن وجهُه حَسَنٌ ... فكيف تطلبه عند ابن عبَّادِ
مشوَّه الخَلْق لا دينٌ ولا حسَبٌ ... كالقِرْد ما عندَه خيرٌ لمُرتَادِ
فقلت: لمن الشّعر؟ فإنه واقع جدّاً.
فقال: هو لأدريس بن أبي حَفصَة.
قلتُ له: كأنه ما عَنَى غير صاحبنا.
وقال له يوماً ابن ثابت: روَى البخاري في " التاريخ " أن سعداً مولى أبي
بكرٍ روَى أن رجلاً شكا إلى النبي صلى الله عليه صفوان بن المعَطَّل،
وقال: إنه هجاني.
فقال: دَعوه، إنه خبيث اللسان طيّب القلب.
فما تأويل: " خبيث اللسان وطيّب القلب " ؟ فقال: البُخاري حشَويٌّ
فُشَرِيّ، ليس عليه مُعوّل، ولا لقوله مُتأوَّل.
وسئل يوماً عن قول الله عز وجل: (فَإنْ يَشَإِ اللهَ يَختِمْ عَلى قَلْبِك
وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِل)، كيف نَظْمه وتمامُه في المعنى واللّفظ؟ فصاح
على السائل وقال: أَ تسأل عن النَّظم، وأنت لا تعرف الرّقم ولا العَقْم
ولا الصَّدْم ولا الرَّدْم؟ وأوصل إليه الوّليديّ مسائل من جماعة من أهل
نيسابور، كان فيها؟ ما معنى: (إِنَّما يَفْتَرِي الكَذِبَ الذِين لاَ
يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ الله وأُولاَئِكَ هُمُ الكاذِبُون)؟ قد علمنا أن من
كذب فهو كاذب.
وكان فيها: ما معنى قوله تعالى: (لا تتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْن)، وقد
علمنا أن إلهين لا يكونان إلا اثنين؟ ولا قناعة لنا بقول من قال: هذا
توكيد؛ فإن المطالبة فوق التوكيد؛ وأضعف المتكلّمين في القرآن من زعم أن
شيئاً منه زائد، وأن كذا وكذا لغوٌ، وأن هذا على وجه التوكيد، ونحن وإن
كنا نعلم أن التوكيد مذهب العرب، وكذلك الزيادة والحذْف والإِضمار،
فالحكمة المطلوبة غير ذلك.
وعرض عليّ الوليدي المسائل، وكان فيها: ما معنى قول الله عزّ وجلّ: (لاَ
تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمينَ)؟ وما وجه قول القائل: " لا
تجعَل " فيما لا يُجعل؟ أو جائز أن يقال للإنسان: لا تنظر برجلك، ولا تمش
بعينك؟ فإنّ قيل: لا، لأن هذا لا يُخاف، قيل: وكذلك لا يجعل الله، أحداً
مع القوم الظالمين، لأن هذا لا يُخاف.
وما معنى قوله: (مَا تَسْبقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا
يَسْتَأْخِرُون)، وقوله: (ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يِا مُوسَى)، وقوله:
(وأَلقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مَنّي)، وعن قوله عزّ وجل: (وَتِلْكَ
الأَيامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ)؟ وما معنى قوله: (لَقَد كَان في
يُوسُفَ وَإخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلينَ)؟ خَبِّرنا عن الآيات، أَ كانت
في أفعالهم أو في أبدانهم؟ وما معنى: (مَنْ يُرِدِ الله فِتْنَتَهُ فَلَنْ
تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولاَئِكَ الذِينَ لَمْ يَرِدِ اللهُ
أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ)؟ وخبِّرنا عن قوله: (وَمَا مِن دَابَّةٍ في
الأَرْضِ إلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقهَا) وعن قوله: (فإِنَّا قَدْ فَتَنَّا
قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِريّ) وما معنى: (وَلاَ
يَزَالُونَ مُخْتَلِفِنَ إِلاّ مَنْ رَحِمَ رَبُّك، ولِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)
أَ لِلاختلاف أم للرَّحمة؟ فإن قيل: للرحمة، قيل: فالمختلفون هم الذين
خلقهم للرحمة، فما معنى: (وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفينَ إِلاَّ مَن
رَحِمَ رَبُّكَ)؟ فقد أخرج من رحم من الاختلاف وللرحمة خلقهم، فإذا كان
كلهم للرحمة خُلقوا فكلّهم غير مختلفين، لأنه نفى عنهم الاختلاف وهم
الجميع، فأين المراد بالآية؟
وقال: (إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ
رَبَّي)، وقال: (فَرِيقٌ في الجَنَّةِ، وفَريقٌ في السَّعيرِ، وَلَوْ
شَاءِ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ
في رَحْمَتِهِ، والظَّالِمونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَليٍّ وَلاَ نَصِيرٍ). أَ
فليس قد أخبر أنه لم يشأ أن يجمعهم على الهُدَى إذ أمرهم؟ وما معنى قوله:
(كَذلِكَ لِنصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ)؟ فإن كان عمَّ بهذا
الكُفّار والمؤمنين فما فضيلة يوسف؟ وإن كان قد خصّ يوسف فهو قَدْح في
النِّحْلة.
وقال: (وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ
يَشَاء اللهُ) مما شاء الله فعله؟ فإن قيل: نعم، فكلّ ما شاء الله كان،
فهذا قولنا، وإن كان مما يشاء فلا يكون، فما وجهُ إِيجاب الأمر بأن لا
يقول لشيء إني فاعل؟ إذ العباد يفعلون وإن لم يشأ الله.
وما تأويل قوله: (أُولاَئِكَ الذِينَ طَبَعَ اللهُ علَى قُلُوبِهمْ
وَسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ)، وقال: (وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ)؟ فبدأ
بالطّبع، ثم ثنّى بالاتباع، وهذا يدفع تأويلكم في قوله: (فَلَمَّا زاغُوا
أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ).
وما تأويل قوله: (وَالذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ
تَقْوَاهُمْ)، وقال: (هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظةٌ
للمُتَّقِينَ)؟ فهو بيان للكفّار، وهدىً وموعظةٌ للمتقين دون الكافرين،
فلم تعُمُّون ما خصَّ الله، وتخصُّون ما عمّ لله؟ وما تأويل قوله:
(وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنين،
وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمينَ إلاَّ خَسَاراً)؟ وما تأويل قوله: (لاَ رَيْبَ
فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) فخصَّ بهدايته أهل التّقوى؟ فإن قيل: هو هُدى
للكافر أيضاً، فكيف وقد ختم القصّة فقال: (إِنَّ الذِينَ كَفَرواُ سَوَاءٌ
عَليْهِم أَ أنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ)، كيف يكون القرآن هدىً
لمن كان سواءٌ عليه أَ أُنذِر أم لم يُنذر.
ويقال: قال الله تعالى: (خَتَمَ اللهُ على قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ
وعلى أَبْصَارِهِمْ)، فهل زال فرض بختمه على قلوبهم؟ فإن قالوا: لا، فقد
كُلِّفوا أن يُبصروا الهدى وقد ختم الله على قلوبهم، وأزالوا الفرض عمن
ختم الله على قلبه وعذروه بكفره، وحطُّوه بمنزلة الصَّبيّ والمجنون.
وإن أبوا أن يقال: لو شاء الله لم يُعصَ، لأن الله ذمّ الذين قالوا: (لَوْ
شاءَ اللُه مَا أَشرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا...)، قيل:
فما تصنعون بقوله: (وَآتَيْنا عِيسى ابنُ مَرْيَمَ البَيِّنَاتِ
وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ القُدُسِ وَلَوْ شَاءِ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا)
واقتتالهم معصية، ولو شاء الله ما عصوا بأن يمنعهم، إذ خلّى بينهم وبين
معصيته؟ وما معنى قوله: (وَلكَنَّ اللهَ يَفعَلُ مَا يرِيدُ).
قال الوليدي: وترددتُ شهوراً ليُجيب عنه فما فعل.
وكان في المسائل أيضاً: كيف يُنفى العلم عن الله وقد أثبته لنفسه في
مواضع، والنصّ لا يُحذف ولا يُتأوّل؛ قال الله تعالى: (أَنْزَلَهُ
بِعِلْمِهِ)، وقال: (فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ)، وقال:
(وَأَضَلَّهُ اللهُ علَى عِلْمٍ)، وقال: (وَلَقَد اخْتَرْناهُمْ عَلَى
عِلْم)، وقال: (...وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ)، وقال: (وَسِعَ
رَبُّنا كلَّ شَيءٍ عِلْماً).
ومن أعرض عن التّنزيل فقد خلع ربقةَ الدين.
وكان إذا رأى كاتباً يقول له: أَ أحكمتَ " الفصيح " ؟ هات: قذَتِ العينُ
ماذا؟ وهات: لَحُم الرجلُ وشَحُم وما في بابِه.
وإذا رأى صاحب لغة قال: ما معنى قول الشاعر:
وأقدَرُ مُشرِف الصّهَوات ساطٍ ... كُمَيتٌ لا أَحَقُّ وَلاَ شَئِيتُ
وإذا رأى نحوياً قال: على ماذا ينتصب (نَذِيراً لِلْبَشَرِ). فإذا أكثر من
هذا وشبهه أنشد:
أَرى الناسَ أَخلاطاً جميعاً وإنهم ... عَلى ذاك شتَّى والهَوَى مُتَفرِّقُ
تَرى المرءَ إِن جالستَهُ ذا صِناعةٍ وسائرُ ما فيه على ذاكَ أخرَقُ
وتَلْقَى أَصيلَ الرأَي ليس لسانهُ ... بمُخرِج ما في قَلْبه حين يَنطِقُ
ورأيته مرةً يسأل الحسنكي:
ما الطَّاية، والثّاية، والغاية، والآية، والرّاية؟ وما الناقة
القاصِية والعاصية والعاطِية؟ وكان سريع الردّ على الإنسان شديد التعجرف،
وكان ذلك ربما انقلب عليه.
وقال يوماً لبعض العلماء في كلام سمعته منه: " أَصْفَيتُهُ كذا وكذا " لا
يجوز، أما قرأت القرآن: (أَ فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالبِنِينَ) إنما
يجب أن تقول: أَصفيته بكذا وكذا.
فقال العالم: هذا صحيح فصيح، وغيره جائز حسن، أما قرأت في الحماسة قول
الشاعر في النسيب:
لئن كُنت أوطَأْتني عَشْوَةً ... لقد كنتُ أصْفَيتك الودَّ حِينا
فقال بعجْرَفَته: الشعر موضع ضرورة.
وكذب، ليس هذا من ذلك.
وحدثني الثقة قال: قال يوماً المسيّبي في حديثه: " وكان يخفر من ذاك
ويستحس " .
فقال له: سخَنت عينك، لا يقال للرجل يخفر، الخفر للنساء.
فقال المسيبي: أيها الصاحب! التؤدة خير من العجلة، أين نحن من قول
الشَّمَرْدل في أَرجُوزته، رواها أبو حاتم:
لا يَسبِقُ النائلَ منه المنكَرُ ... فتىً شِتاءً يَسْتحي ويَخْفَرُ
فقال: أخذنا في الحماقة.
وقال مرّة: " ضَرَّه وأضرَّ به " ، ولا يجوز أضَرَّه، كذا لا يجوز ضرَّ به.
فقال له رجل من خُراسان: فما تقول في قوله عز وجلّ: (وَمَا هُم
بِضَارِّينَ بِهِ مِن أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ)؟ فقال للرجل: اخسأ!
أَ هذا من ذاك؟ وأخجل الرجل في صوابه، ولم يخجل هو من خطئه لسقوطه وجهله
ومُكابرته وحسده.
وقال يوماً: النَّكث للعهد، والخلف للوعد؛ و لا يجوز: نكث الوَعْد، وكذا
لا يجوز: أخلفتَ العهد.
وكان بيت القرآن والرواية حاضراً أبو الحسن ابن شاذان فقال: هذا مرفوض
بقوله تعالى: (قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ
اللهُ عَهْدَهُ).
فبرَد، وكان بارداً، لا رحم الله صداه ولا بلَّ ثراه.
وقال في بعض الليالي: الاقتراف لا يكون إلاّ في القبيح، أما سمعت الكلام
الذي هو كالمثل: " الاعترافُ يمحُو الاقتراف " ؟ فقال له مٌقرئ قد حضر:
التنزيل يأبى هذا الحُكم وينطق بغيره.
قال: وما ذاك؟ قال: قال الله تعالى: (وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ
لَهُ فِيَها حُسْناً)، فخَزِي وقام.
ورأيته يناظر أبا الفرج البغداديّ الصُّوفي، وكان في أُذنه وقرٌ، في وساوس
الصوفية وخطراتهم، فقال: يا أبا الفرج! إذا كانت البينونة مشعوراً بها في
عرصة الحقح حيث لا عبارة للخلق، ولا أمان للجلِّ والدِّقّ، بطنت وسائل
المعرفة بحقائق المراد، واشتبهتْ أعلام الحال في تثبيت الإشارة، وبقيت
العبارة على إِلف الآلف، وعادة المتالف.
فأجابه أبو الفرج: لا ثبات لمناسب البينونة في نهايات الاتحاد، لزوال
شرائط رسوم الخلق عند تصافي الأرواح بحقائق الحق. قال ابن عبّاد: ما أُنكر
تلاشي المناسب في نهايات الاتحاد، إذا سطعت أنوار الحقيقة بالاتّقاد؛
وإنما جررت الكلام إلى غاية تزلق فيها الأفهام، وتسيخ فيها الأوهام، ولا
يُشرف عليها إلا نمن خصه الحق بخصائص التّمام، ورفع معارف جملة العوامّ؛
ولولا الحال التي امتحنني الحق بها، وسحبني على غرائبها وعجائبها، في عُرض
صوادقها وكواذبها، مما هو مردود إليه، ومتوكّل فيه عليه، لشققت معك جلباب
صدرٍ قد حُشي ودائع، وفتحت لك أبواب خزائن قد جمعت فيها بدائع؛ ولكني بما
تراني أُذَبذب عليه مأخوذ، وبما تسمعني أُدندن حوله مأخوذ. وإلى الله
المشتكى، فهو الغاية والمنتهى.
ثم قال: يا أبا الفرج! هل تعرف من أصحابك من يقول:
بُليتُ بما لو يُبتَلَى أحد به ... لأَصبَحَ كالعِهْنِ النَّفِيش يَطيشُ
بِعِشْقٍ وإِعراضٍ وشَوقٍ وغُربة ... ومَحْك الذي أَهوى فكيف أَعيشُ
وأَعجَبُ مِن ذا أَنّني متصَوّف ... ولكنّ صُوفَ العاشِقين حَشيشُ
وقلت لأبي السلم نجبة بن عليّ القحطاني الشاعر: قد لقيتَ ابن العميد، وها
أنت تُشاهد ابن عبّاد، فصفهما لي؛ فإنك رجل بدويّ، وتنظر إلى كلّ شيءٍ
بفطرتك، وتنطق عن كل شيءٍ بسابق فِطنتك.
فقال: أما ابن العميد - يعني أبا الفضل - فكان بحره لا يُنزف وبرُّه لا
ينسف، وغُباره لا يُشقّ، ونسيمه لا يُنشَق، وحبّه لا يفرك وأديمه لا
يُعرك؛ على بُخلٍ كان به أحال نهاره ليلاً، وألصق به ثبوراً وويلا.
وأما هذا - يعني ابن عباد - فليس في استحسانه لإحسانه فضل
لاستحسانه لإحسان غيره، قد غرق في بحر نفسه، فليس يرفع طرفه إلى أحد من
بني جنسه؛ وهذا الذي يدل على غاية نقصه.
وقلت للحيلوهي يوماً: كيف ترى ابن عباد؟ فقال: كما قال الشاعر:
كَبَرْقٍ لاَحَ يُعْجِبُ مَنْ رَآهُ ... وَلاَ يَسْقي الحَوَائِمَ مِن
لَمَاقِ
ونظر إليه يوماً وقد طلع في موكبه فتمثّل بقول الشاعر:
وَأنتَ كَغَيْث السُّوء مَن يَرَ بَرقَهُ ... يَشِمْه ومن يَحلُل به فهو
جادِبهْ
ومن شعر ابن عباد، وهو يتملّح به عند نفسه، قوله في رجل تزوّجت أمُّه:
عذَلتُ لِتزويجه أُمَّه ... فقال: فعلتُ حلالاً يجوزْ
فقلتُ: حلالٌ كما قد زعم ... تَ ولكن سَمحتَ بصَدع العجُوزْ
وقال أيضاً:
زوَّجتَ أُمَّك يا أَخِي ... فكسَوتَني ثوبَ القلَقْ
والحرُّ لا يُهدِي الحُرُ ... مُ إلى الرجال عَلَى طبَقْ
وقلت لأبي الفرج الصوفي البغدادي: أنت شيخ صوفي، ولك ذكر جميل، لمَ تتعاطى
لهذا الرجل - أعني ابن عباد - الكلام في الزُّهد والدَّقائق والأضْمار
والوَساوس وتصفية الأعمال؟ هذا علم يُذاكر به أصحاب الحُرَق، وأرباب
الخِرق.
فقال: هذا رجل رقيع رفيع، وله جاه ومالٌ وهو مُطاع، ولست أصل إلى ما في
يده إلا بالرَّقاعة، وأنا ثقيل الظَّهر بالعيال محتاج إلى القوت، فأحمق له
ساعة حتى أنال منه هذا الحُطام الذي قد تهالك عليه الخاصّ والعام، وقد قال
الأول:
فحامَقْتُهُ حتى يقال سَجِيةٌ ... ولو كان ذا عَقلٍ لكنت أُعاقِلُهْ
وسمعته يقول، وقد جرى حديث ابن العميد أبي الفضل، فقال: لم يكن له - مع
فضله الشائع، وأدبه ابارع - علم الدين، ولا كان عنده شيء من الشريعة؛ كان
لا يعرف القرآن وأحكامه وغريبه وإعرابه، واختلاف العلماء فيه بضروب
التأويل وغرائب التفسير؛ والرئيس إذا عري من هذا السِّربال فهو ممقوت عند
الله تعالى، مقلي عند الناس. وكان إذا سمع كلاماً في الدين ثقُل عليه،
وخنس عنه، وقطع على الخائض فيه، وكان إذا احتفل في العلم والحكمة وما يدل
على الخصوصية قال: لمَ صارت الأشياء المتعادية في حياتها تتعادى بعد
مماتها أيضاً وتتنافر؟ كَمِعَى الذّئب وجلد الشاة، وكسنّ السِّنَّوْر
وعظْم الفارة.
ولمَ الصبيُّ إذا ولد أزرق فأرضعته حبشيةٌ عاد أشْهِل، فإن دامت عليه عادَ
أكحل؟ ولم لا يتغلغل شعره كما اسودّت حدقته؟ ولم يُنسب الضَّب إلى العقوق،
والهرَّة إلى البرّ، وهما يتشابهان في أكل أولادهما؟ قال: ويقول في دقيق
علمه وغامض حكمته: قيل لسِّنَّورة: لم تأكلين جراءك على فرطِ حُبّك لها؟
قالت: يُخيل إلينا أكبادنا أولى بأن تكون فيها، من الأماكن التي تحويها.
قال: ومن جُملة ذلك أيضاً: لمَ يكوت السِّعلاة من الضَّربة الأُولى، وتعيش
بالضّربة الثّانية؟ ولم صار الفرس لا طحال له، والبعير لا مرارة له،
والظَليم لا مخَ لعظمه؟ ولم ليس في السّباع أطيب أفواهاً من الكلاب، وليس
في الوحش أطيب أفواهاً من الظّباء؟ وكيف صار الأسد أشدّ الحيوان بَخَرا
وكذلك الصقر؟ ولم صار الكلب أسبح من سائر السّباع؟ ولم صار حيتان البحر لا
ألسنة لها ولا أدمغة؟ ولم صار صَفَن البعير لا بيضة فيه؟ ولم صارت السّمكة
لا رئة لها؟ ولم صار في فؤاد الثّور عظم؟ ولم صارت البراغيث تجتمع على
السّوط متى دُهن بشحم قُنفذ أو مُسح بمُصران ابن عُرس؟ ولم صار الزّنبور
يموت في الزّيت ويعيش في الخلّ، كما تموت الخُنفساء في الورد وتعيش في
الرّوث؟ ولم صار الضَّب يأكل الجراد ويسالم العقارب، وهي " أشبه بها من
الماء بالماء " ؟ - في حماقات كثيرة، الجهل بها أحمد من العلم بها.
هذا من تشنيعه على أبي الفضل، وكان مع ذلك ربما قال: كان واحد الدنيا؛
وهذا كما ترى، وهو يدخل في باب المناقضة.
والأمر الذي تشدّد فيه - أعني ابن عباد - وبلَغ الحدّ الأبعد
منه، وزاد على جميع الناس فيه: باب المخاطبات، وأنه كان يطالب أصناف الناس
بما ليس في الطّاقة ولم تجرِ به عادة، وكان يقول: هذا الذي به أجد طعم
ولايتي، ولولا هذه اللّذة والشهوة ما باليتُ أن أتقلّب في مُرقَّعة خلق،
وثوب رثٍ بال، أجوبُ بلاد الله، وألقى عباد الله، وآكل رِزق الله.
ولقد خُدع في هذا عن أموال خطيرة اختلست فتغافل عنها، إما عن جهلٍ وجنون،
لأنه كان يسوم كلّ من كتب إليه أن يُكنِّي عن نفسه بالعبودية، وعنه
بالمولوية، ثم يعرض في هاتين الكنايتين، وكناية الحديث والشأن، ومن الحديث
عنه، أو له، أو فيه، فربما تشاجرت كنايات وتداعت معانيها على الكاتب فلا
يخلص إلى تحقيق مراد، واستبانة وجه، وهذا الذي أقوله يعرفه الذي دُفع إليه
ودُهي به.
وقال لي ابن ثابت: قلت له: كيف كان الخليفة يرضى بأن يقال له: أعزّه الله،
وكذلك وليُّ العهد، والوزير، ومن قاد الجيش وأغنى في الهبوة، ومن أمر على
شطْر الدنيا؟ وكان ابن الزيات يقال له يا أبا جعفر، وابن أبي دُوَاد يقال
له: يا أبا عبد الله.
فقال: كان الناس في ذلك الوقت ضِعاف العقول صغار الهِمم، ولم تكن لهم
مَرائر مُغارة، ولا نفوس فيها غزارة.
هكذا قال. وهذا - حفظك الله - كلام جاهلٍ لا خبرة له بشيء من أمور الدنيا
والدين، وهو مع ذلك دليل على النَّذالة والسقوط.
وجرى يوماً حديث المخاطبات عند القاضي أبي حامد المرورّرذي والترتيب فيها،
وامتعاض الناس من التصارف الجاري بين أهلها، فقال: سبب هذا كلّه إحساس
الناس بنقصهم القائم بهم، الرّاكد عليهم، النّابت فيهم؛ وطلب دفع ذلك
بالترتيب، ونفيه بالخطاب؛ وليس الطّريق إلى هذا، بل الطريق إليه الأخذ
بأخلاق من سَلف: من الحياء والكرم والدين والمروة. انظر إلى السلف الصالح
كيف كانوا، هل خاطبوا رسول الله - صّلى الله عليه - إلاّ بيا رسول الله؟
وبعدُ فهل يخاطب ربنا إلا بالتاء وإلاّ بالكاف؟ وهل سمعت عبداً لله قد
أخلص دينه له قال: إن رأى ربنا فعل بعبده كذا وكذا؟ وهل الخير كله إلا
فيما خص الله به نبيّه وأُمته، وأشاع فيهم حكمته وبركته.
ثم قال أبو حامد: وينبغي أن لا يكون بينك وبين أصدقائك صرف، لأنّ الصداقة
فوق ذلك، بل المصارفة فيها تُقذيها وتفسدها، وتحيل نضارتها، وتبدّل
غضارتها، وقد تستحيل الصداقة بالمصارفة عداوة، لأنّ التجني والاستزادة
يَعتَوِرانها، والاعتداد والاحتجاج يَمحقانها؛ فأما النُّظراء والأكفاء
فيكفي معهم أن يكون الجواب كالابتداء، والآخر كالأول.
وكان أبو محمد النُّباتي يقول في هذا الباب كلاماً طيباً، وأنا أحكيه لأنه
موضعه وإن تنفَّست الرسالة، فالغرض فائدة، وإن كان سبب إنشائها الغيظ الذي
فاض الصّدر به، ومرح اللسان بوصفه، وقد قال ابن الرومي:
وَمَا الحِقْدُ إلا تَوءَمُ الشُّكْرِ في الفتَى ... وبعضُ السَّجايا
ينتَسِبْن إلى بَعْضِ
فحيْثُ تَرى حِقداً عَلَى ذِي إسَاءَةٍ ... فَثَمّ تَرى شُكراً على حَسَن
القَرْضِ
إذا الأَرضُ أدَّت رَيْعَ ما أنتَ زارِعٌ ... من البَذْر فيها فهْي ناهِيك
من أَرض
فهذا هذا.
قال: جميع ما يتقلّب فيه من هذه الأمور الفاسدة والأحوال الرديّة، يرجع
إلى أصول أربعة، وهي: الحماقة والرّقاعة والرُّعونة والجنون.
فأما الحماقة فما عليه الكتاب من المخاطبات المختلفة التي ليس فيها حقيقة،
ولا ترجع إلى صحّة، لا من جهة الديانة ولا من جهة رسم الأولين السّادة،
وإنما هو شيء يؤدّي إلى القال والقيل وإلى العداوة والمغالبة، ويبعث على
الوحشة الشديدة بالاستشعار الرديّ، والوسواس الموديّ؛ لأن الترتيب إن كان
بينك وبين من هو دونك فهو على الدلالة على محلك،وإن كان إلى نظيرك، فهو
على غاية المماثلة بينه وبينك، وإن كان إلى من فوقك فهو على توفية ما
يستحقه منك.
قيل له: ها هنا قسم آخر، والدّاهية كلها منه.
قال: وما هو؟ قيل: الذي يدّعي أنه نظير لك وهو دونك، والذي هو فوقك وتدّعي
أنه في حدّك، وها هنا يشتدّ النّزاع والفراع، وتتحطّم القنا ويتطاير
الشّرر، ويجد الشيطان مدخلاً منه، وتسويلاً به.
فقال: هذا من فقد التناصف في الأصل، وإلا فالحال مُفضية في التحقيق إلى
الكلام الأول.
ثم قال: وأما الرقاعة فانتفاش القُضاة والشهود، ألا تراهم كيف
يوسّعون أكمامهم، ويعرّضون جيوبهم، ويُرخون أطواقهم، وينظرون إلى الأرض
تعظُّماً على من يُكلِّمهم، وتبرّؤا ممن يخالفهم؟ ألا ترى إلى دنياتهم
وقرامعتهم وقلانسهم وعمائمهم وتحنبُلهم وتقتُّلهم؟ فهم كما قال الشاعر:
وأَنت باللّيل ذِئبٌ لا حريمَ لَهُ ... وبالنّهار عَلَى سمت ابن سِيرينِ
وإذا تكلم أحدهم خفض صوته، وقطّع حروفه، وسبّح في خلال ذلك، وقال: عافاك
الله اسمع! ويا هذا أصلحك الله! ويا عبد الله الصالح! قُل خيراً، ولا قليل
من الله، ويا فُلان! اتّق ربك الذي إليه معادك، أما عليك حفظة من قِبَل
الله؟ أما للإسلام عندك حُرمة؟ أما تؤمن بالله؟ أما تؤمن بيوم الحساب؟
قال: وأما الرّعونة فما عليه الشُّطّار من هؤلاء الشباب الجلد الذين
يرفعون الحجر، ويدّعون الفتوّة، ويُكثرون ذكرها ويحلفون بها، ويسمّونها "
الجوامَرْدِية " ، ترى أحدهم يضيّق الأكمام ويحلّ الأزرار، ويفتُل
السِّبال، ويمشي متحاملاً، ويتكلم متصاوِلاً.
قال: وأما الجنون فما تجد عليه هؤلاء الذين يتنازعون بينهم قولهم: أبو بكر
خير من عليّ، وعليٌّ خير من أبي بكر؛ وإذا حلفوا قالوا: وقدر عليّ، وحقّ
الصدّيق؛ ويقولون: بغداد أطيب من البصرة، وبادية البصرة أخف من بادية
الكوفة، والرّازقي خير من البارقيّ، والسُّونائي أحلى من الكرخي،
وسامَرَّة فوق " إِرَمَ ذاتِ العِماد " ، وفلان فضلي، وفلان مرعوشي؛ وترى
لهم في هذا الطريق اهتماماً وإنفاقاً وقوة ومغالبة ومشاغبة ومحاكمة
وملاطمة؛ وهكذا إذا جرى حديث الشاعر والشاعر، كالعوفي والنّاشي، والامح،
والقاصّ كالبربهاري والقسري.
وقد صدق هذا الشيخ، فقد سمعنا من هذا ما لا يطمع في إحصائه.
وقال الزّعفراني الشاعر: كيف يكون هذا الرجل - يعني ابن عباد - دياناً
ومتألّهاً، وهو يبتذل العلوية والأشراف، ويٌهينهم أعوانه، وهم يعدون بين
يديه فلا ينكر ذلك منهم؛ ولقد فال يوماً، وهو يريد الركوب لبعض حُجّابه:
نظف الطريق من هذه الخنافس والجُعْلان والحرابي والغِربان.
فقلت لبعض من كان إلى جانبي: من يعني؟ فقال: يعني هؤلاء الواردين من
الحجاز لسواد ألوانهم وتفلفل شعورهم، ودَمامة وجوههم وانحطاط قدودهم، وقلة
دَماثتهم واختلاف حركاتهم وشَمائلهم.
قال: أَ فهذا من التشيّع والولاء وما يجب لهذا البيت؟ ثم يدّعي أنه زيدي،
فإذا قرض قصيدة غلاَ، وزاد على العَوْفي والنَّاشِي.
وأما أنا فما رأيت أحداً من خلق الله في حدّته سفه لسانه؛ خرج يوماً من
دار مؤيد الدولة من باب غامض هرباً من قوم كانوا يرقبونه على الباب
المشهور من السَّحَر الأعلى، وهو وحده بين يديه رِكابي، فعرفته عجوز فقامت
في وجهه ودعت له، ومدّت يدها بقصعةٍ معها فقال: ما تريدين يا بظراء يا
بخراء يا عَفلاء يا فقماء؟ على هذا إلى تباعد، فبقيت العجوز مبهوتة،
وقالت: مسكين هذا الرجل، قد جُنّ.
فقلت لبعض أصحابه: ما هذا النّذل والفُحش والخِفّة والطّيش؟ فقال: هذا
دأبه إذا جاع.
فقلت: أجاع الله كبده وسلبه نعمته! وحدثني العتّابي قال: الرجل لا دين له؛
سمعته يقول في الخلوة، وقد جرى حديث المذهب: كيف أنزل عن هذا المذهب، يعني
الاعتزال، وقد نصرته وشهرت به نفسي، وعاديت الصغير والكبير، وانقضى عمري
فيه؟ قلت للعتابي: ومن أين وقع في هذا الإلحاد؟ فقال: لم يزل مترجّحاً
قليل الطُّمأنينة سيءَ اليقين، ولكن أهلكه مُقعدة الذي يقال له النَّصيبي
أبو إسحق.
وصدق هذا الشيخ؛ كان أبو إسحق شاكاً في النبوّات، وكان يُصادقبهذا من
صافاه ووثق به، وهو الذي قال بنكده وخُبثه: لو ظفر يوم الجمل طلحة
والزُّبير وعائشة بعليّ بن أبي طالب، دار الخلاف بينهما، وكان لا يعوّل
أحدهما في الاستظهار على صاحبه إلا بأن يتزوج عائشة، ثم يكافح صاحبه بها
وبشيعتها الذين فتُّوا بعر جَملها وتشافوا به، وتحاثّوا عليه، وكنا نحن
نكوّر عمائمنا ونرفع طيالسنا ونسرّح لحانا ونكتحل ونحتفل، ثم نجلس في
المساجد والجوامع ونحتّج لذلك التّزويج، ونتأول كلّ قولٍ، ونخرّج كلّ خبر،
ونبلغ كل غاية بكل حيلة.
وحديث التاجر المصري من الطرائف؛ قدم شيخ له هيئة ومعه ثياب مصر،
فدعا به، واشترى منه، وتقدّم بإكرامه، ورفع الحجاب عنه، وقال له: أهل مصر،
أي شيء يغلب عليهم من فنون العلم، وبرسائل من يشغفون؟ فقال التاجر: لهم
حرص على كل علم، ونصيب من كل أدب، وأما الرسائل فإنهم لا يؤثرون على ما
لابن عبد كان الكاتب أبي جعفر شيئاً؛ وكان نجاح الخادم قائماً؛ فأومى إلى
المصري بأن قل: رسائلك هي المطلوبة والغريبة، وهي المُشتهاة والمستعملة،
وكان إيماؤه باليد، والإصبع، والحاجب، والشَّفة، وهذا كله لا يُفصح عن
حرف، فلم يكن يفهم التاجر لشقائه معنى الإشارة؛ وانقبض عنه ابن عباد ولم
يحاوره، وقام ذاك على حالةٍ قد ناله فيها فتور لا يدري ما سببه.
فلما كان بعد أيام حضر أيضاً وأعاد القول على الوجه، فأعاد المصري الجواب
المتقدّم، ونجاح الخادم على رسمه قائم يُشير بمثل ما أشار إليه في المجلس
الأول، وهذا لا يفطن، وفي أهل مصر سلامة صدرٍ شبيهة بغباوة طَبْع.
فالتفت ابن عباد إلى الخادم وقال: إذا كان صاحبك سخين العين قطيع الظَّهر،
ابن بظْراء، إيش يمكنك أن تعمل؟ وطرد المصري.
أَ فهل هذا إلا رقاعة تحتها جنون صرف، وسرطان في الدّماغ، وعلّة في العقل،
وفساد في المزاج؟ واسمع ما هو أعجب من هذا! ناظر بالريّ اليهودي رأس
الجالوت في إعجاز القرآن، فراجعه اليهودي فيه طويلاً، وثابته قليلاً،
وتنَّد عليه حتى احتدّ وكاد ينقدّ؛ فلما علم أنه سَجَر تنُّوره وأسعط
أنفه، احتال طلباً لمُصاداته، ورفقاً به في مُخاتلته، فقال: أيها الصاحب!
ولك تتقد وتشتط، ولم تلتهب وتختلط؟ كيف يكون القرآن عندي آيةً ودلالةً على
النبوّة، ومعجزة من جهة نظمه وتأليفه؟ وإن كان النظم والتأليف بديعين
غريبين، وكان البُلغاء، فيما تدّعي، عنه عاجزين، وله مُذعنين، وها أنا
أُصدق عن نفسي وأقول: عندي أن رسائلك وكلامك وفقرك وما تؤلفه وتباده به
نظماً ونثراً هو فوق ذلك أو مثل ذلك، أو قريب منه؛ وعلى كل حال فليس يظهر
لي أنه دونه، وأن ذلك يستعلي عليه بوجه من وجوه الكلام، أو بمرتبة من
مراتب البلاغة.
فلما سمع ابن عباد هذا فتر وخَمد، وسكن عن حركته، وانخمص ورمُه به وقال:
ولا هكذا أيضاً يا شيخ، كلامنا حسن وبليغ، وقد أخذ من الجزالة حظّاً
وافراً، ومن البيان نصيباً ظاهراً؛ ولكن القرآن له المزية التي لا تُجهل،
والشرف الذي يُخمل؛ وأين ما خلقه الله تعالى على أتمّ حُسن وبهاء، مما
يخلقه العبيد بتطلُّب وتكلُّف؟ هذا كله يقوله، وقد خبأ حميُّه، وتراجع
مزاجه، وصارت ناره رماداً؛ مع إعجاب شديد قد شاع في أعطافه، وفرح غالبٍ قد
دبَّ في أسارير وجهه؛ لأنه رأى كلامه شُبهةً على اليهود وعلى عالمهم
وحَبرهم، مع سعة حيلهم وشدّة جدالهم، وطول نظرهم وثباتهم لخصومهم.
فكيف لا يكون شُبهةً على النصارى، وهم ألين من اليهود عريكةً، وأطفؤهم
نائرة، وأقلّهم مِراء، وأكثرهم تسليماً؛ وأنه إن جاز هذا على اليهود
والنّصارى، وهم دهماء الناس، فما ظنّك بالمجوس ونصيبهم من الجدل أقلّ، وهم
عن النّظر أعجز، وعادتهم في المحاجَّة أفسد؛ وهكذا الصابئون؟ انظر - أكرمك
الله - إلى هذا الرجل العظيم الطّاق الفسيح الرِّواق، الذي لا يرضى أحداً،
كم ينخدع وكم يذوب! مرةً للشاذياشي، ومرة لليهودي، ومرة للتاجر المصري،
ومرةً للخُراساني، ومرةً للبغدادي.
فهل هذا إلاّ النّوك والرَّكاكة، وضعف النَّحيزة، وسوء التخيّل، وقرب
الغَور، وقلة العقل؟ قال أبو سليمان المنطقي: وعنده يومئذٍ أبو زكرياء
الصَّيمري، وقد قرأت عليه هذه الأحاديث: هذا رجل قد سعد في الدنيا سعادة
عجيبة مُذ ولي إلى الغاية، وهي شُقّة عمره وآخر أمره، لم يُشك بشوكة،ولم
ينكب بنكبة، ولم يسمع من أحد كلمةً عَوراء، ولم يدفع في حالةٍ إلى آبدة،
وقد بلغ في حياته ما شاء.
فقال أبو زكرياء: النّحس الذي لحقه في عقله حتى صار لذلك رقيقاً
أهوج سيّء الأدب، حديداً كثير الكذب، شديد التلوّن، عسير المأتى، ممقوت
العُجب، عظيم الكبر، طويل الخُصومة، دائم المِراء، وقَّاعة في أهل الفضل،
حاسداً لذوي الأدب، مغتاظاً على ذوي المروءات، مناناً بالقليل، معظّماً
للتافه النزْر، وذوي الدين، مقروناً بالأُبَن - هو أعظم من جميع ما أُعطيه
من المال الكثير، والمرتبة العالية، ومن الخيل المَسوَّمة، ومن الدّور
والقصور، وما فيها من العين الحور، والخزائن والذخائر، والفضّة والذهب،
والجواهر والخدم والعبيد؛ لأن العقل إذا صحّ فهو المنيحة التي لا يوازيها
شيء، وإذا اختلّ فهو البَلوى التي لا يتلافاها شيء؛ ولو كان مع هذا العقل
عارياً من جميع ما عددناه، لعلاه بعض العامّة بكيسه ولُطفه، ولبرز عليه
بعض أصحاب الخُلقان بمروّته وظرفه، " وَلَكِنّ الغِنَى رَبٌّ غَفُورُ " .
ولهذا أحسن الذي يقول:
ذَرِيني للغِنَى أَسْعَى فإِنِّي ... رأَيتُ النَاسَ شَرُّهم الفقيرُ
وأَبعدُهم وأَهونُهم علَيْهم ... وإِن أَمسَى له كَرَمٌ وخِيرُ
ويُقْصِيه النَّدِيُّ وتَزدريه ... حَليلَتُه، وينهرُه الصّغيرُ
وتلقَى ذا الغِنَى وله جَلالٌ ... يَكادُ فؤادُ صاحِبهِ يَطيرُ
قليلٌ ذَنبُه والذَّنبُ جَمٌّ ... ولكنَّ الغِنَى ربٌّ غَفُورُ
وله مع الغنى أمر ونهي، وقوة سلطان، وجد ودولة؛ فكل عيبه مستور، وكل فضله
منشور.
قال له أبو سليمان: صدقت، وهذا لأن الإنسان لا يكون في هذا العالم مالكاً
للتمام، جامعاً لأدوات الكمال؛ وسببه أنه نتيجة للكواكب العالية، والأجرام
الشريفة، من المواد المختلفة، والعناصر الصافية والكدرة؛ فمتى نالته سعادة
بالمُشتري، وصل إليه نحس من زُحل، وكذلك الزُّهرة والمرِّيخ؛ والعلماء
المتقدمون يقولون: المشتري والزهرة سعدا الفلك، والزُّهرة مخصوصة بالسعادة
العاجلة، والمُشتري مخصوص بالسعادة الآجلة.
قال: وهذا وإن كان في الجملة كما قاولوا، فلالتباس الدنيا بالآخرة، فما
يُستفاد من المشتري كثير من حظوظ الدنيا، ويستفاد من الزهرة كثير من حظوظ
الآخرة.
ومن أسرار الزهرة أنها ربما هيّأت الوحي، ومن أسرار المشتري أنه ربما هيّأ
اللّهو.
ومرّ له في هذا لفن كلام كثير مفيد ندَّ عنّي، ولم يصحب ذهني إلا ما تسمع.
قال: ولهذا كان نحس ابن العميد في بدنه، لأنه فقد الصحة في وسط عمره، وحين
الحال حويل، والمال مويل، والعلم نزر، والقهم ناقص، والبلاغة خلق،
والكتابة شمطاء؛ فلما أخذت أحواله تتّسق، وأسباب فضله تستوسق ضُرب في بدنه
بالعلل الشديدة، والأمراض المختلفة، وسُلب لذّة المطعم والمشرب، وبقيت
حسرة النّعمة في نفسه إلى أن عطب؛ وقلة حظه منها هو الذي كان يبعثه على
قلة الإنعام منها.
قال: ولهذا تجد آخر جيد العقل، صحيح البدن، محمود البيان، ولكنك تجده مع
ذلك شديد الفقر، سيء الحال، مرحوم الجملة. وعلى هذه الجديلة كل من اعتبرت
حاله، وعرفت ما سلبه مما وُهب له، وما أُعطيه مما حُرمه، وهذا ليكون العبد
أبداً في منزلةٍ من النقص، وحالٍ من العجز يكون بهما ضارعاً إلى خالقة،
طالباً لعنايته من مالكه، وليكون بين العبد المعجون من الطّين وبين الله
مُدبّر الخلق فرق.
وذهب في هذا الفضل كل مذهب، وشفى كل غليل، وأبكى كل عين، وكان ذا قوة
عجيبة في هذه الطّريقة، وذا اطّلاع إلى أسرار الخافية.
فأما حديثي معه، فإن حين وصلت إليه قال لي: أبو مَن؟ قلت: أبو حيّان.
قال: بلغتي أنك تتأدّب.
قلت: تأدُّب أهل الزمان.
قال: فقل لي، أبو حيان ينصرف أولاً؟ قلت: إن قِبله مولانا لا ينصرف، فلما
سمع هذا تنمّر وكأنه لم يعجبه، وأقبل على واحدٍ إلى جانبه فقال له
بالفارسية سفهاً، على ما فُسِّر لي.
ثم قال لي: أنا سامع مُطيع.
ثم قلت في الدّار لبعض الناس مُسترسلاً: إنما توجّهت إلى العراق إلى هذا
الباب، وزاحمت منتجعي هذا الرّبع، لأتخلّص من خرزة الشُّؤم؛ فإن الوراقة
لم تكن ببغداد كاسدة.
فنُمي إليه هذا أو بعضه، أو على غير وجهه، فزاده تنكُّراً؛ وكان
الرجل خفيف الدماغ، لا يعرف الحلم إلا بالاسم؛ والسُّؤدد لا يكون ولا يكمل
ولا يتم إلا بعد أن يُنسى جميع ما يُسمع، ويتأول ما يكره، ويؤخذ بالأسَدّ
فالأسَدّ.
وقال أبو سعيد السيرافي: الحِلْم مشارك لمعنى الحُلُم؛ فصاحب الحِلم هو
الذي يُعرض عما يرى ويسمع كالحالم، واللفظ إذا واخى اللفظ كان معناه
قريباً من معناه، وهذا الخَلْق والخُلُق، والعَدْل والعِدْل، وسست الرجل،
وسست المرأة.
وقال لي يوماً آخر، أعني ابن عباد: يا أبا حيّان! من كنّاك أبا حيان؟ قلت:
أجلّ الناس في زمانه، وأكبرهم في وقته.
قال: من هو ويلك؟ قلت: أنت.
قال: ومتى كان ذلك؟ قلت: حين قلت لي: يا أبا حيان.
فأضرب عن هذا الحديث وأخذ في غيره على كراهة ظهرت عليه.
وقال لي يوماً آخر، وهو قائم في صحن داره، والجماعة قيام: منهم
الزُّعفراني، وكان شيخاً كثير الفضل، جيد الشعر، مُمتع الحديث؛ والنّميمي
المعروف بسَبطل وكان من مصر؛ والأقطع، وصالح الورّاق، وابن ثابت، وغيرهم
من الكتّاب والنّدماء: يا أبا حيّان! هل تعرف فيمن تقدّم من يُكنّى بهذه
الكُنية؟ قلت: نعم، من أقرب ذلك إلى أبو حيّان الدّارمي.
حدثنا أبو بكر القاضي محمد بن محمد الدقاق، قال: حدثنا ابن الأنباري، قال:
حدثنا ابن ناصح، قال: دخل أبو الهُذيل العَلاّف على الواثق، فقال له
الواثق: لمن تعرف هذا الشعر:
سَباكَ من هاشمٍ سليلُ ... ليسَ إلى وصْله سبيلُ
من يتّعاطى الصّفاتِ فيه ... فالقولُ في وصفه فُضول
للحُسْن في وجهه هِلالٌ ... لأَعْيُنِ الخلق ما يَزُولُ
وطُرّة لا يزالُ فيها ... لنُور بَدْر الدُّجَى مَقيلُ
ما اختالَ في صحْن قَصْر أَوسٍ ... إلا تسَجَّى له قَتيلُ
فإِن يَقِفْ فالعيون نُصْبٌ ... وإِن تولَّى فهُنَّ حولُ
فقال أبو الهذيل: يا أمير المؤمنين! هذا لرجل من أهل البصرة يُعرف بأبي
حيان الدّارمي، وكان يقول بإِمامة المفضول. وله من كلمة يقول فيها:
أَفضّله والله قدَّمه على ... صَحابته بعد النّبي المكرَّمِ
بلا بِغْضَةٍ والله مني لغيرهولكنّه أولاهم بالتقدُّمِ
وجماعة من أصحابنا قالوا: أنشدنا أبو قِلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي
لأبي حيان البصري:
يا صاحبيَّ دعَا الملامةَ واقصُرا ... تَركُ الهَوى يا صاحبيَّ خسارة
كم لمتُ قلبي كي يُفيقَ فقال لي: ... لَجَّتْ يمينٌ ما لهَا كفّارَه
أَن لا أُفيقَ ولا أُفتّر لحظةً ... إِن أَنت لم تعشق فأَنتَ حجاره
الحبّ أوَّل ما يكون بنظرةٍ ... وكذا الحريق بداؤه بِشَرَاره
يا مَن أُحبّ ولا أُسمّي باسمها ... إِياكِ أَعني واسمعي يا جارَه
فلما رويتُ الإسناد، وأنشدت الشعر، وريقي بليل، ولساني طَلق، ووجهي متهلل،
وقد تكلّفت ذلك وأنا في بقيّة من غَرر الشباب وبعض ريعانه، فملأتُ الدار
صياحاً بالرواية والقافية، فحين انتهيت أنكرت طرفه، وعلمتُ سوء موقع ما
رويت عنده.
قال: ومن تعرف أيضاً؟ قلت: روى الصُّولي - فيما حدثنا عنه المرزباني: أن
معاوية لما حُضِر أنشد يزيد عند رأسه متمثلاً:
لو أن حيّاً نَجَا لفَاتَ أبو ... حيّان لا عاجزٌ ولا وكلُ
الحُوَّلُ القُلَّب الأَريب وهل ... تَدفع صَرفَ المنية الحِيَلُ
قال الصّولي: هذا من المعمّرين المعَقّلين.
وانتهى الحديث من غير هَشاشة منه عليه، ولا هزّةٍ ولا أريحية، بل على
اكفهرار الوجه، ونُبوّ الطَّرْف، وقلّة التقبُّل. وجرت أشياء أُخر، وكان
عُقباها أنني فارقتُ بابه سنة سبعين وثلاثمائة راجعاً إلى مدينة السلام،
بغير زادٍ ولا راحلة، ولم يعطني في مدّة ثلاث سنين درهماً واحداً، ولا ما
قيمته درهم واحد. فاحمل هذا ما أردت.
ولما نالني منه هذا الحرمان الذي قصدني به، وأحفَظَني عليه،
وجعَلني من بين جميع غاشية وِرْدِه فرداً، أخذت أتلافى ذلك بصدق القول
عنه، في سوء الثّناء عليه، والبادي أظلم، وللأمور أسباب، وللأسباب أسرار،
والغيب لا يُطّلع عليه، ولا قارع لبابه.
وسألت العماري عنه فقال: الرجل ذو خَلَّة، ولقد سأله ليلةً شيخ من خُراسان
في الموسم عن قوله عزّ وجلّ: (وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ في الدُّنْيَا،
وإِنَّهُ في الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) ما مرتبة الصّلاح المذكور في
الثاني من النبوّة الثابتة في الدنيا؟ فأضْرَب عن المسألة ودافع بصدرها،
ولم يُجْرِ كلمةً فيها.
وسأله هذا الشيخ ليلةً أخرى عن قوله عزّ وجلّ: (وَوَاعَدْنا مُوسَى
ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ)، وعن الفرق بين هذا
الاقتصاص وبين قوله: (وَوَاعَدْنا مُوسَى أرْبَعِينَ لَيْلَةً)، فما أعاد
ولا أبدى.
ولما عاد من همذان، قيل له: كيف رأيت أبا الوَفاء؟ قال: سَراباً بِقِيعة.
قيل: فكيف مجدت عبد العزيز بن يوسف؟ فقال: نكَداً وخديعة.
قيل: فكيف وجدت المجوسي؟ قال: تمثالاً في كنيسة أو بِيعة.
قيل: فابن سَعدان؟ قال: ضخم الدَّسيعة، له من نفسه حَرىً وسيعة.
هذا حديثه في دينة، ورأيه وعلمه وعقله ومروّته وصناعته ومذهبه. وقد طال
وكثُر، ولعلّ التقصّي لو وقع لازداد طولاً، فإنه تنفّست أيامه وتردّدت
أحاديثه.
سألت ابن الجلباب الشاعر عنه، فقال: ما أدري ما أقول في رجلٍ من قرنه إلى
قدمه عيب وخزيٌ ونذالة ورقاعة، على أن الطبع النكد أملَكُ له، والعادة
القبيحة أغلب عليه؛ والإقلاع عن المنشأ المُعان بالطِّباع صعب وعر، ولعلّه
مُمتنع.
وسألت الحاتمي عنه، فقال: رأيت رجلاً مدخولاً في جميع الفضائل، مردوداً
على كل التأويلات؛ لتِيهه وإعجابه، وحسده ولوثته، وقلّة مصافاته، وسوء
رعايته، وفساد دُخلته، ووقاحة وجهه، وشدّة تعييره، وفشوّ أُبنَته، وقُبح
سيرته في مذهبه، ونُصرته لما يعتقد بقلبه.
وسألت البديهي عنه، فقال: خذ حديثه بما تسمع مني، وقس عليه؛ رأيت يوماً
على بابه شيخاً من أهل الكتاب والأدب ذكر أنه وَرد من مصر، وأنه أقام بها
زمناً، وأن أصله من بلاد العجم؛ فلما خرج إليه رفع قصّةً كتب على رأسها:
عبّاد بن أحمد، فأخذ ونظر، ثم قال: من سمّاك عباداً باسم الأمين رضي الله
عنه؟ ومن يقول إن هذا اسمك الذي اختِير لك عند الولادة؟ وما هذا التقرّب
بالتكذيب؟ وما بينكم وبين أسماء السّادة الذين بانوا بها كالسّماء
بكواكبها، والأفلاك بعجائبها؟ أما كان لك بغير هذا الاسم الذي ادّعيته
دَرْك؟ ولا كان لك دون التكثّر به سبب؟ ما أحوجك إلى نقاف يوجع يافوخَكَ،
ونتّاف يقلع شاموخك؟ وسألت الصابيّ أبا إسحق عنه فقال: إن صدقتُ في وصفه
ساء قوماً، وإن كذبت في وصفه ساءني؛ ولأن أنفرد بالمساءة أحبّ إليّ؛ وبعدُ
فنحن معه كما قال الشاعر:
ونعتب أَحياناً عليهِ ولو مضَى ... لكنّا عَلَى الباقي من الناس أعتَبَا
وقلت للضبعي: كيف ترى هذا الرجل وقد خبرته؟ فقال: أما جَدّه فيُريني أنه
واحد الدنيا، وأما جِدّه فينطق بأنه أنذل من في هذا الورى.
وبعد:
نِعْمةُ اللهِ لا تُعَابُ ولكِن ... ربما استُقْبِحَتْ عَلَى أَقوامِ
وقلت للمأموني: اصدقني عن هذا الرجل، فقد عرفت ليله ونهاره، والليل أصدق
عن خبايا الإنسان من النّهار.
فقال: في الجملة الرجل بلا دين، لفِسقه في العمل وارتيابه في العلم.
وسألت أبا صادق الطبري عنه فقال: سل عن البَخْت، والله ما له سمتٌ يُتوجّه
إليه منه، ولا باب يُعتمد منه عليه؛ بينا هو لك، إذ صار لعدوّك، حاله
أحوال، وشأنه شؤون، وكل ذلك جارٍ على الجنون.
وقلت لابن المراغي: كيف تراه؟ قال: والله ما يشفي الغليل منه هجْوٌ ولا
مَلام، ولا ما هو معروف به بين الخاص والعام، إلا أن يسقط من ذروته فيُرى
في حال سِقطته متردّداً بين خطبته وورطته.
وقلت للشيخ العالم: أما أنت من بين الناس فقد حظيت عنده، ونلتَ منه.
فقال: لو عرفت ما يتّقد على فُؤادي من الغيظ عليه لرحمتني في بَلائي بأكبر
مما تحسدني عليه في ظاهر أمري.
قلت: وما تنكر منه؟ قال: لستُ أنكر منه شيئاً واحداً، وإنما أُنكره كله.
وقلتلأبي جعفر الورّاق: ما أراك تخرج من حضرة هذا الرجل إلا وأنت
ساهم الوجه، مغيظ النفس؛ كأنك لست تخرج من عند من كل أحدٍ يتمنّى أن يصل
إليه، وأن ينطق بين يديه، وأن يصنع به حاله؟ فقال: والله لولا التحرج
لوصفته بكلامٍ كان فيه برد حرارة صدري، ولكن التحرّج مانع من ذلك، هذا،
والخوف أيضاً عامل عمله، وآخر ما أقول: أنه ساقطٌ من عين الله عزّ وجلّ،
والويل له من الله يوم التَّجازي والقصاص.
وقلت لأبي الفضل الهروي: كيف ترى هذا الرجل؟ قال: أراه - والله - عقوبة من
الله نازلة بأهل الفضل والتكرم، وليتنا علمنا بأي ذنبٍ عُوقبنا فكُنّا
ننتهي عنه ولا نُصرّ عليه، فما عندي أن الله يبتلي عبداً من عباده بخدمته
والتعلُّق به بعد أن ينزع عنه العصمة، ويوكِّل به النِّقمة، ويحرِّم عليه
الرّحمة.
وقلت للزّعفراني الشاعر: بالله صِف لي هذا الرجل.
فقال: لو أمكنني الوصف بالنظم كان أعجب إليّ؛ فإني رجل شاعر، ولكن الخوف
من ذلك حائل.
وقلت للتميمي: أما أصحابك فقد عرفت عقائد قلوبهم في هذا الرجل. فأين أنت
منه؟ فقال: أحرى اعتقادي فيه أنه خنزير قد أُعطي قوة أسد؛ فهو يفترس يمنةً
وشآمة، وكنت أرى فيما مضى أن الشرّ مكسوب بالقصد حتى شاهدتُ هذا فتحولت عن
الرأي الأول، وقلتُ: بل السرّ في بعض الناس لاصق بالطّبع.
وقلت لأبي سعيد الأبهري: بيّن لي أمر هذا الرجل، ففي نفسي أن أعمل كتاباً
في أخلاقه.
فقال لي: لقد حاولت عسيراً. أَ تستطيع أن تصف إبليس بجميع ما هو فيه؟ قلت:
لا والله، إنما أعوذ بالله منه فقط.
قال: فعُذْ بالله من هذا قبل أن تعوذ بالله من إبليس؛ فإن إبليس - وإن كان
شريراً - فهو عاقل، وهذا يزيد عليه لأنه شرير وهو أحمق.
وقلت لأبي طاهر الأنماطي: كل أحد له على هذا الرجل كلام، وفي نفسه مَوجدة
سِواك؛ فإنك واصل إليه إذا أردت ونائل من ماله وجاهه إذا أحببت، فما قولك
فيه؟ فقال: صبري على رقاعته قد نغَّص عليّ جميع ما أنا عليه معه، على أن
رقاعته مُرشحة بجنون، وجنونه صادر عن قدرة، فالرّهبة منه قد كدّرت عين
الرّغبة فيه، والغيظ عليه قد منع من الاستمتاع به.
وسألت ابن زرعة الفقيه فقلت: ما أحوجني إلى فُتياك في هذا الرجل! فقال: قد
- والله - جُبْتُ الآفاق، ولقيتُ أصناف الناس في الشرق والغرب، فما رأيت
رجلاً في جنونه أعقل منه، ولا في عقله أجنّ منه، وإنه لأعجوبة؛ عدوّه هالك
لسلطانه، ووليّه خائف من كثرة ألوانه؛ لا عهد له ولا وفاء، ولا صدق ولا
لطف، كله هزْل، وجميعه جهل.
وقلت لابن فارس صاحب اللغة: بِم تحكم على هذا الإنسان؟ فقال: بأنه لله
عدوّ، وللأحرار مُهين، ولأهل الفضل حاسد، وللعامّة مُحبّ، وللخاصّة مُبغض.
فأما عداوته لله فلقلّة دينه.
وأما إهانته للأحرار فهي شهيرة كهذا النّهار.
وأما حسده لأهل الفضل جرِّب ذلك بكلمة تُبديها.
وأما حبُّه للعامّة فبمناظرته لهم وإقباله عليهم.
وأما بغضه للخاصة فلإذلاله لهم وإقصائه إياهم.
**** فأما ابن العميد أبو الفضل، فإنه كان باباً آخر، وطامّة أخرى، وكان
فضله من جنس ليس لابن عباد فيه نصيب، ونقصه من ضرب لم يكن له فيه ضريب،
كان يُظهر حلماً تحته سفه، ويدّعي علماً هو به جاهل، ويُري أنه شجاع وهو "
أجبن من المَنْزُوف ضَرْطاً " ، وكان يدّعي المنطق وهو لا يفي بشيء منه،
ولم يقرأ حرفاً على أحد، ويتشبّع بالهندسة وهو منها بعيد، ولم يكن معه من
صناعة الكتابة الأصل وهو الحساب، وكان أجهل الناس بالدّخل والخرج، ولقد
بقي ما بقي في أيامه فما قعد يوماً في الديوان ناظراً في عمل، أو فاصلاً
لحكم، أو مخلصاً لمشكل، وكان قد وضع في نفسه - بالحيل الدقيقة، والأسباب
الخافية - أنه واحد الدنيا، وأن ملوك الأرض يحسدونه عليه، وأنه لسان
الزمان، وخطيب الدهر؛ وأن قلمه فوق السّيف، وتدبيره فوق الجيش، ونظره في
الدّولة والمملكة وأحوال الأولياء وذوي النصيحة كالوحي والنبوّة. وكان
مُعَوَّله في الأعمال على أبي علي البيّع؛ وكان مع هذا شيّء السيرة، قليل
الرحمة، شديد القسوة، وارم الأنف، عظيم التيه، شديد الحسد لمن نطق ببيان،
أو أفصح بالعربية وسيتبيّن بعض هذا بما أذكره لك بشاهد عدل، وراوٍ ثقة.