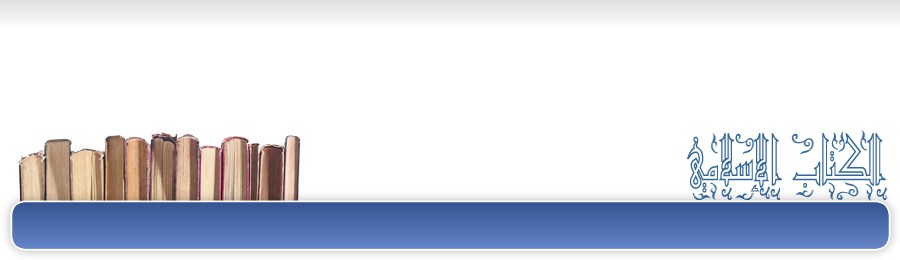كتاب : تلخيص الخطابة
المؤلف : ابن رشد
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
تلخيص
المقالة الأولى
من الخطابة
قال: إِن صناعة الخطابة تناسب صناعة الجدل، وذلك إِن كليهما يؤمان غاية واحدة: وهي المخاطبة؛ إذ كانت هاتان الصناعتان ليس يستعملها الإنسان بينه وبين نفسه كالحال في صناعة البرهان، بل إنما يستعملها مع الغير؛ وتشتركان بنحو من الأَنحاءِ في موضوع واحد، إذ كان كلاهما يتعاطى النظر في جميع الأشياءِ، ويوجد استعمالها مشتركا للجميع: أعني إِن كل واحد من الناس يستعمل بالطبع الأَقاويل الجدلية والأَقاويل الخطبية. وإِنما كان ذلك كذلك، لأَنه ليست واحدة منهما علما من العلوم منفردا بذاته. وذلك إِن العلوم لها موضوعات خاصة، ويستعملها أَصناف من الناس خاصة. ولكن من جهة إِن هذين ينظران في جميع الموجودات وجميع العلوم تنظر في جميع الموجودات، فقد توجد جميع العلوم مشاركة لهما بنحو ما.وإذا كانت هاتان الصناعتان مشتركتين، فقد يجب إِن يكون النظر فيهما لصناعة واحدة: وهي صناعة المنطق.
وكل واحد من الناس يوجد مستعملا لنحو ما من أنحاءِ البلاغة ومنتهيا منها إِلى مقدار ما وذلك في صنفي الأَقاويل اللذين أحدهما المناظرة، والثاني التعليم والإِرشاد. وأكثر ذلك في الموضوعات الخاصة بهذه الصناعة، وهي مثل الشكاية والاعتذار وسائر الأَقاويل التي في الأُمور الجزئية.
ويوجد كثير منهم يبلغون مقصودهم بهذا الفعل. فمن الناس من يفعل ذلك بالاتفاق؛ ومنهم من يفعله بالاعتياد وبملكة ثابتة. ومعلوم إِن الذي يفعل هذه الصناعة بملكة ثابتة أفضل من الذي يفعلها بالاتفاق. وإِذا كان ذلك كذلك، فالذي يفعلها بملكة ثابتة وعلم بالسبب الذي به يفعل فعله أتم وأفضل. وهذا أمر يعرفه الجمهور فضلا عن الخواص. ولذلك كان واجبا إِن تُثبت أجزاءُ هذه الصناعة في كتاب، ولا يقتصر على ما يوجد من ذلك بالطبع فقط، و لا بالاعتياد، كالحال في كثير من الصنائع القياسية.
قال: وكل من تكلم في هذه الصناعة ممن تقدمنا، فلم يتكلم في شيء يجرى من هذه الصناعة مجرى الجزء الضروري، والأَمر الذي هو أحرى إِن يكون صناعيا: وتلك هي الأُمور التي توقع التصديق الخطبي، وبخاصة المقاييس التي تسمى في هذه الصناعة الضمائر، وهي عمود التصديق الكائن في هذه الصناعة، أعني الذي يكون عنها أولاً و بالذات.وهؤلاءِ فلم يتكلموا في الأَشياءِ التي توقع التصديق الخطبي بالجملة، و لا في الضمائر التي هي أحرى بذلك؛ وإِنما تكلموا فأكثروا في أشياء خارجة عن التصديق، وإِنما تجرى مجرى الأَشياءِ المعينة في وقوع التصديق، مثل التكلم في الخوف والرحمة والغضب و ما أشبه ذلك من الانفعالات النفسانية التي ليست معدة نحو الأَمر المقصود تبيينه أولاً وبالذات، وإنما هي معدة نحو استمالة الحكام و المناظرين ولذلك كانت كأنها موطئة للتصديق، لا فاعلة له.
قال: فلو كان إِنما يوجد من أجزاءِ الخطابة الشيء الذي هو موجود الآن منها في بعض المدن، لما كان لما تكلم هؤلاءِ فيه من الخطابة جدوى ولا منفعة، وإن كان قد تكلموا فيها تكلما جيدا، وهي المدن التي لا تبيح السنة فيها التكلم بين يدي الحكام بالأَشياءِ التي تمُيل الحكام وتستعطفهم إِلى أحد المتكلمين، بل إِنما تباح فيها الأُمور التي توقع التصديق فقط.وذلك إِن أهل المدن يلفون في هذا الوقت فريقين: فمنهم من يرى أنه ينبغي إِن تُثبَّت السنن التي يؤدب بها أهل المدينة في نفوس المدنيين بجميع الأُمور التي لها تأْثير في التصديق، كانت أشياء توقع التصديق أو أُمور خارجة، ومنهم من يمنع إِن يذكر شيء من الأُمور التي من خارج، وبخاصة عند الحكام على ما كان عليه الأَمر في موضع الحكومة في أثينيا وفي بلاد اليونانيين.
قال: ورأْيُ من رَأى إِن استعمال جميع الأَشياءِ التي لها تأْثير في التصديق في تثبيت الأَشياءِ التي يراد تثبيتها بطريق الخطابة هو الصواب.
وخليق إِن استعمل أحد هذا القانون إِن يكون باستعماله يصير في هذه الصناعة لبيبا أديبا.
وقد يدل على إِن الأُمور التي من خارج ليس لها كبير جدوى في هذه
الصناعة إِن الذي يروم إِن يثبت شيئا بين يدي الحكام فهو إِما إِن يثبت
إِن الشيء موجود أو غير موجود فقط، أعني أنه كان أو لم يكن، وذلك إِذا كان
قد حدد صاحب الشريعة إِن ذلك الشيءَ الذي فيه الشكوى عظيم أو يسير، وأنه
عدل أو جور، وإِما إِن يثبت الأَمرين، وذلك إِذا لم تحدد الشريعة ذلك
الشيء الذي فيه الكلام فأما استعمال الانفعالات في تثبيت إِن الأَمر عدل
أو جور فغير ممكن، وذلك إِن الانفعال بالرحمة أو البغضة إِنما يكون لشيءٍ
جزئي، والعدل والجور أُمور كلية.وأما استعمالها في إِن الأَمر كان أو لم
يكن فله في ذلك تأْثير لكنه ليس يوجب إِن الأَمر كان أو لم يكن بالذات، بل
إِنما يُميل الحكام إِلى إِن يقولوا إِنه صدَق فيما ادعى أو لم يصدق، من
غير إِن يحدث للحاكم أو المناظر بذلك تصديق زائدا بالشيء الذي فيه الكلام.
قال: وقد يجب إِن تكون السنن هي التي تحدد إِن الأَمر جور أو عدل، وتفوض
إِن الأَمر وجد من هذا الشخص أو لم يوجد إِلى الحكام.وبالجملة: فتفوض
إِليهم الأُمور اليسيرة.وذلك لسببين: أما أولا فإِنه قل ما يوجد حاكم يقدر
إِن يميز الأُمور على كنهها، فيضع إِن هذا الأَمر جور وهذا عدل في الأَقل
من الزمان.وأكثر الحكام الموجودين في المدن في أكثر الزمان ليس لهم هذه
القدرة.
وأما ثانيا فلأَن الوقوف على إِن الشيء عدل أو جور يحتاج واضع السنن فيه
إِلى زمان طويل، وذلك لا يمكن في الزمان اليسير الذي يقع فيه التناظر في
الشيء بين يدي الحكام.
فلمكان هذين الأَمرين يصعب إِن يُفَوض إِلى الحكام إِن هذا الأَمر عدل أو
جور أو نافع أو ضار، بل إِنما يُفَوض إِليهم إِن الأَمر وقع من هذا الشخص
أو لم يقع، وذلك لبيانه، ولأَنه أمر لا يمكن إِن يضعه صاحب السنة.
قال: وإِذا كان الأَمر هكذا، فمعلوم إِن هؤلاءِ الذين تكلموا في الأَشياءِ
التي من خارج، أني في صدور الخطب وفي الاقتصاص وفي الانفعالات وما يجري
هذا المجرى، لم يتكلموا في شيءٍ يجري من الخطابة مجرى الجزء، وإِنما
تكلموا في أشياء تجري مجرى اللواحق.فأما الأَشياءُ التي تكون بها
التصدبقات الصناعية - وهي أول ذلك الضمائر - فلم يتكلموا فيها بشيءٍ.
ومن أجل أنا نحن نرى إِن الضمائر عمدة هذه الصناعة، نعتقد إِن المخاطبة
التي تكون على جهة التشاجر والتنازع بين يدي الحكام والمخاطبة التي تكون
على جهة الإِرشاد والتعليم هي لصناعة واحدة، وهي هذه الصناعة، و أما
هؤُلاءِ الذين تكلموا في هذا الجزء من الخطابة فقد يلزمهم ألا ينسبوا من
الكلام في هذه الصناعة إِلى هذه الصناعة إِلا ما كان منه على جهة التنازع
والتشاجر وليس في كل الأَصناف التي يتشاجر فيها، بل في الصنف الخسيس منها،
وهي الأًمور السوقية التي يتشاجر فيها بين يدي الحكام.وأما التشاجر الذي
يكون في وضع السنن فليس ينتفع فيه بالجزءِ الذي تكلم هؤلاءِ فيه من
الخطابة.إِذ كان هؤلاءِ لم يتكلموا في الضمائر بشيءٍ.لكن لما تكلموا في
الأَشياءِ التي بها يخسس الشيء أو يفخم، ظنوا أنهم قد تكلموا في جميع
الأَشياءِ التي تستعمل فيها الأَقاويل الخطبية.واستعمال الأَشياء التي من
خارج في الخطابة، دون استعمال الأَشياء التي هي من نفس الأَقاويل الخطبية،
فعل خسيس.
وليس لقائل إِن يقول: إِن الأَقاويل التي تكون في التشاجر قد
يستغنى فيها بالأُمور التي من خارج عن الشيءِ الذي هو من نفس الأَمر، إِذ
كانت السنن في أكثر المدن هي التي ترسم ما هو جور وما هو عدل وعظيم أو
صغير، فليس يحتاج في هذا النوع من الخطابة إِلا لما يُميل الحكام فقط،
وذلك بخلاف الأَمر في الأَقاويل التي تستعمل في الأُمور المشاورية.فإِن
الأَقاويل المشيرة بما يفعل بذوي الجنايات مما هو نافع أو ضار أيسر على
الخطيب من الأَقاويل المشاجرية فيهم، أعني التي تثبت فيهم أنهم جاروا أو
عدلوا.وليس هذا في ذوي الجنايات فقط.وهذه حال التكلم في الأَشياءِ
المشاورية مع التكلم في الأَشياءِ المشاجرية.وذلك إِن الحكام إِنما يحكمون
في الأَشياءِ التي يشار بها بأُمور معروفة عند الجمهور، وهو إِن هذا الشيء
الذي يشار به نافع أو ضار، فلا يخاف من الحكام إِن يحيفوا فيه.وإِذا كان
الأَمر على هذا، فليس يحتاج المتكلم بين أيديهم إِن يثبت أكثر من إِن
الأَمر نافع أو ضار، فيوافقه الحكام على ذلك، ولا يمكن إِن يخالفوه
لاستواءِ معرفة الجمهور مع الحاكم في النافع والضار.وأما المتكلم بين يدي
الحاكم في الأُمور المشاجرية فقد ينبغي له إِن يتحفظ من الحكام في قضائهم
إِن هذا عدل أو هذا جور، لأَن معرفة العدل والجور هو شيء غريب عند
الجمهور، وإِنما يعرفه القوام بالشريعة.فلذلك يمكن إِن يسلم الحاكم
للمتكلم الشيء الذي رام تثبيته، ولا يفضى له بما فيه من الجور أو العدل،
فيحتاج المتكلم بين أيديهم إِن يعرف الأَشياء التي هي جور والتي هي عدل،
والأَشياء التي يثبت بها أنها عدل أو جور.
ولمكان هذا تمنع السنة في مدن كثيرة إِن يتكلم بين يدي الحاكم في الأشياء
التي تمُيلهم وتستعطفهم عن أحد المتنازعين.وإِنما يباح لهم التكلم بين
أيديهم بأشياء محدودة مما رسمها واضع السنة.
وأما المتكلم في الأُمور المشورية فليس يحتاج إِلى مثل هذا التحرز.فإِن
الحكام يبالغون في التحفظ من إِن يقولوا في الشيء النافع إِنه ليس بنافع
أو في الضار إِنه ليس بضار، إِذ كان ذلك مما يحط منزلتهم عند الجمهور
لاستواءِ علمهم به وعلم الحكام.وإِذا كان الأَمر هكذا، فإِذن ما يحتاج
إِليه الخطيب في الأُمور المشاجرية من معرفة الأَشياءِ التي توقع التصديق
أكثر مما يحتاج إِليه الخطيب في الأُمور المشاورية.
قال: ومن أجل أنه معلوم إِن الأَشياء المنسوبة إِلى هذه الصناعة إِنما
يقصد بها التصديق والاعتراف من المخاطب بالشيء الذي فيه الدعوى، وذلك لا
يكون إِلا بتثبيت الشيء عنده المعترف به، وذلك أنا إِنما نعترف بالشيءِ
إِذا رأينا أنه قد ثبت عندنا.والشيء الذي نثبت به الأَشياء على طريق
الخطابة هو الضمير، لأن هذا هو أصل التصديق وعموده في الأُمور التي توقع
هذا النحو من التصديق، أعني التصديق البلاغي.
والضمير هو نوع من القياس.ومعرفة القياس هو جزء من صناعة
المنطق.فقد يجب إِن يكون صاحب المنطق هو الذي ينظر في هذه الصناعة: إِما
في كلها، وإِما في أجزاءٍ منها.وبينّ إِن الذي يعرف القياس من كم شيء
يلتئمُ ويكون، ومتى يكون، فهو أقدر على عمل الضمير ممن يعرف الضمير فقط
دون إِن يعرف القياس الذي هو جنسه.والذي يزيد على هذا فيعلم لماذا تعمل
الضمائر والفصول التي بين الضمير وبين سائر المقاييس التي تستعمل في
الصنائع الأُخر فهو أقدر من ذينك.والمعرفة بهذا كله إِنما هو لصناعة
المنطق.فإِن للقوة الواحدة بعينها، أعني للصناعة الواحدة بعينها، إِن تعرف
الشيء الذي هو حق والذي هو شبيه بالحق.والتصديقات الخطبية، وإِن لم تكن
حقا، فهي شبيهة بالحق.وأيضا فإِن الناس متهيئون بطبيعتهم كل التهيئة نحو
الوقوف على الحق نفسه، وهم أكثر ذلك يؤمونه ويفعلون عنه.والمحمودات وهي
التي تكون منها الضمائر شبيهة بالحق من قبل أنها نائبة عند الجمهور مناب
الحق، والشبيه بالحق قد يدخل في علم الحق الذي هو علم المنطق.وإِذا كان
الأَمر هكذا، فقد استبان إِن قصور هؤلاءِ فيما تكلموا فيه من أمر الخطابة
إِنما كان من أجل أنه لم يكن عندهم علم بالمنطق، وأن سائر من تكلم في
الخطابة ومن يستعمل الأَقاويل الخطبية فقط من غير إِن يتقدموا فيعرفوا هذه
الأَشياء التي هي عمود البلاغة، إِنهم إِنما يتكلمون في أشياء تجري من
البلاغة مجرى التزيين والتنميق الذي يكون في ظاهر الشيء وصفحته لا في
الأَشياءِ التي تتنزل منها منزلة ما به قوام الشيء ووجوده، وإِن كان قد
يظن بما فعلوا من ذلك أنهم قد بلغوا الغاية من الأَقاويل الإِقناعية وجروا
في ذلك على طريق الصواب والعدل.
قال: وللخطابة منفعتان: إِحداهما إِن بها يحث المدنيين على الأَعمال
الفاضلة، وذلك إِن الناس بالطبع يميلون إِلى ضد الفضائل العادلة.فإِذا لم
يضبطوا بالأَقاويل الخطبية، غلبت عليهم أضداد الأَفعال العادلة، وذلك شيء
مذموم يستحق فاعله التأنيب والتوبيخ، أعني الذي يميل إِلى ضد الأَفعال
العادلة أو المدبر الذي لا يضبط المدنيين بالأقَاويل الخطبية على الفضائل
العادلة.وأعني بالفضائل العادلة التي هي فضائل بين الإِنسان وبين غيره،
أعني بينه وبين المشارك له في أي شيء كانت الشركة، لا بينه وبين نفسه.
و المنفعة الثانية أنه ليس كل صنف من أصناف الناس ينبغي إِن يستعمل معه
البرهان في الأَشياءِ النظرية التي يراد منهم اعتقادها، وذلك إِما لأَن
الإِنسان قد نشأ على مشهورات تخالف الحق، فإِذا سلك به نحو الأَشياء التي
نشأ عليها سهل إِقناعه، وإِما لأَن فطرته ليست معدة لقبول البرهان أصلا،
وإِما لأَنه لا يمكن بيانه له في ذلك الزمان اليسير الذي يراد منه وقوع
التصديق فيه.فلهذا قد نضطر إِلى إِن نجعل التصديق بالمقدمات المشتركة
بيننا وبين المخاطب، أعني بالمحمودات.وهذه المنفعة تشارك هذه الصناعة فيها
صناعةَ الجدل، كما ذكرنا ذلك في كتاب الجدل عند قولنا في الأَشياء التي
يمكننا بها إِن نبين مطلوبات مختلفة.
وهذه الصناعة يمكنها الإِقناع في المتضادين جميعا، كما يمكن ذلك
في القياس الجدلي.وذلك أنا قد نقنع في ذي الجاني أنه أساءَ وأنه لم يسيء،
ولست أعني أنا نفعل الأَمرين جميعا في وقت واحد، بل نفعل هذا في وقت، وهذا
في وقت بحسب الأَنفع، وذلك أنه كثيرا ما يكون الشيءُ نافعا في وقت، وضده
نافعا في وقت آخر.وأيضا فإِنه إِذا كانت الأَشياءُ التي تثبت الشيءَ وضده
عندنا عتيدة، وسمعنا متكلما قد أقنع في الضد الذي ليس بعدل، أمكننا بهذه
القوة إِن ننقض عليه قوله.فهاتان المنفعتان موجودتان في القدرة التي في
هذه الصناعة على الإِقناع في الشيءِ وضده.وليس توجد هذه القوة في شيء من
الصنائع القياسية إِلا في هاتين الصناعتين، أعني صناعة الخطابة وصناعة
الجدل.وكلا هاتين الصناعتين هما مهيئتان بالطبع وعلى السواءِ للإِقناع في
كلا المتقابلين، أعني أ،ه ليس واحدة منهما توجد أشد استعدادا للإِقناع في
أحد المتقابلين منها في الآخر، بل الاستعداد الموجود فيها على الإِقناع في
المتقابلين هو على السواء.فأمما الأَشياءُ الموضوعة لهاتين الصناعتين،
أعني الأَشياء التي فيها تقنع وبها تقنع، فليس استعدادها لقبول الإِقناع
على السواءِ، ولا جدوى الإِقناع فيها على السواء.لكن إِذا كانت الأُمور
التي تقنع فيها صادقة، كانت الأَقاويل الخطبية والجدلية التي تستعمل فيها
أفضل وأبلغ.
قال: وليس واجبا إِن نرى أنه قبيح بالإِنسان إِن يعجز عن إِن يضر بيديه،
ولا نرى أنه قبيح إِن يعجز عن إِن يضر بلسانه الذي المضرة به مضرة خاصة
بالإِنسان، أعني إِن يعجز عن إِن يضر بلسانه الضرر العظيم، لا الضرر الذي
هو عدل فقط، بل و الضرر الذي هو جور.فإِنه يظن إِن هذا شيء يوجد عامَّا في
جميع الفضائل التي هذه الصناعة واحدة منها، ما عدى الفضيلة النظرية و
الخلقية، ولا سيما في الأُمور العظام النافعة مثل الجلَد والصحة واليسار
والسلطان وما أشبه هذه الأَشياء من الأُمور النافعة، أعني إِن كل واحد من
هذه الخيرات هي معدة لأن ينفع بها المقتنى لها غيره منفعة عظيمة إِذا
استعمل العدل، ويضر بها ضررا عظيما وذلك إِذا استعمل الجور.فإِن الصحة
والجلَد والسلطان قد يستعملها المرءُ في الضرر والنفع، وكذلك الحال في
الخطابة.فقد استبان من هذا إِن هذه الصناعة ليس تنظر في أحد المتقابلين،
ولكنها تنظر فيهما على السواءِ، كالحال في الجدل، وأنها نافعة لهذا جدا.
وليس عمل هذه الصناعة إِن تقنع ولا بد، أعني أنه ليس يتبع فعلها الإِقناع
ضرورة، كما يتبع فعل النجار وجود الكرسي ضرورة، إِذا لم يكن هنالك عائق من
خارج، بل عملها هو إِن تعرف جميع المقنعات في الشيءِ وتأًتى بها في ذلك
الشيء، وإِن لم يقع إِقناع.والحال فيها في هذا المعنى كالحال في صناعات
كثيرة مثل صناعة الطب، فإِنه ليس فعلها الإِبراء ولا بد، بل إِنما فعلها
إِن تبلغ من ذلك غاية الشيء الممكن فعله في ذلك الشيء المقصود
بالإِبراء.ولذلك قد يشارك في أفعال هذه الصنائع مَنْ ليس مِنْ أهلها، مثل
إِن يبرئ مَن ليس بطبيب، ويقنع مَنْ ليس بخطيب.لكن الفعل الحقيقي إِنما هو
لصاحب الصناعة، وذلك إِن الغاية تتبع فعل هذا على الأَكثر، وذلك على
الأَقل.
وكما إِن في الجدل ما هو قياس وما يظن به أنه قياس، وليس بقياس،
وهو القياس السوفسطائي، كذلك في الأَقاويل المقنعة المستعملة في هذه
الصناعة ما هو مقنع بالحقيقة، وما يظن به أنه مقنع من غير إِن يكون
كذلك.لكن لما كان السوفسطائي ليس إِنما يكون سوفسطائيا من قبل القوة
والملكة التي بها يفعل الأَقاويل السوفسطائية، بل إِنما هو سوفسطائي من
قبل ما يقصد بتلك الأَقاويل من الكرامة والخيرات الخارجة، وذلك لإِيهامه
أنه حكيم، وكان الجدلي إِنما هو جدلي بالملكة الحاصلة له عن الصناعة،
فبالواجب لم تكن الأَقاويل السوفسطائية جزءًا من صناعة الجدل، أعني التي
يظن بها أنها مقاييس جدلية من غير إِن تكون جدلية، إِذا استعملت نحو هذه
الغاية، وأما إِذا استعملت على طريق الامتحان فهي جزء منها.وأما الخطيب
فلما كان قد يكون خطيبا من أجل الأُمور التي من خارج مثل الكرامة وغير ذلك
من سائر الخيرات، وقد يكون خطيبا من قبل ملكة هذه الصناعة، كانت الأَقاويل
التي يظن بها أنها مقنعة وليست بمقنعة جزءًا من هذه الصناعة، لأَن المقصود
بهذه الأَقاويل في هذه الصناعة قد يكون بعينه مقصود السوفسطائي.وِإنما كان
ذلك كذلك لأَن المقصود بهذه الصناعة من الذي يراد إِقناعه إِنما هو الفعل
أو الانفعال.فإِذا حصل ذلك منه، فلا فرق بين إِن يكون حصوله عن أقاويل هي
مقنعة في الحقيقة أو عن أقاويل يظن بها أنها مقنعة، وليست بمقنعة.فإِن كان
ذلك الفعل المقصود من المخاطب أو الانفعال خيراً ما له، لا للخطيب، كانت
الأَقاويل التي يظن بها أنها مقنعة وليست بمقنعة داخله في هذه الصناعة
بالجهة التي دخلت في صناعة الجدل الأَقاويل التي يظن بها أنها جدلية وليست
بجدلية، إِذا لم يقصد بها مقصد السفسطة.وإِن كان مقصود الخطيب خيراً يناله
من الخيرات التي يقصدها السوفسطائي، كان يقول الذي يظن به أنه مقنع وليس
بمقنع من جهة ما هو سوفسطائي جزءًا من هذه الصناعة، إِذ قد يشارك الخطيب
السوفسطائي في غايته، فلذلك قد تدخل الأَقاويل السوفسطائية في هذه الصناعة
ولا تدخل في صناعة الجدل.
قال: فهذه الصناعة التي ذكرنا منافعها وأن كل مَنْ تكلم فيها لم يتكلم
فيها بما هو كافٍ في أمرها التي قصدنا للكلام فيها من أول الأَمر، وذلك
بأن نخبر من أي شيء تأْتلف هذه الصناعة، وكيف تأْتلف وما تكلمنا فيه قبل
هذا فكأنه لم يكن لنا مقصودًا أولاً، ولذلك قد ينبغي إِن نستأْنف هاهنا
القول فيها ونعود إِلى مقصودنا كأنا مبتدئون من هذا الموضع، فنبتدئئ أَولا
ونحد هذه هذه الصناعة فنخبر ما هي ونحو ماذا، وذلك بأن نعرف جنسها القريب
وفصلها الخاص بها، ثم نتطرق من ذلك إِلى إِحصاءِ أجزائها على جهة تحليل
الحد.
قال: والخطابة هي قوة تتكلف الإِقناع الممكن في كل واحد من الأَشياءِ
المفردة.ويعني بالقوة: الاصناعة التي تفعل في المتقابلين وليس يتبع غايتها
فعلها ضرورة.ويَعني بتتكلف: إِن تبذل مجهودها في اسقصاءِ فعل الإِقناع
الممكن.ويعني بالممكن: الإِقناع الممكن في ذلك الشيء الذي فيه القول، وذلك
يكون بغاية ما يمكن فيه.ويعني بقوله في كل واحد من الأَشياءِ المفردة، أي
في كل واحد من الأَشخاص الموجودة في مقولة مقولة من المقولات العشر.
وهذا هو الفصل الذي به تنفصل هذه الصناعة عن سائر الصنائع التي يظن بها
أنها قد تقنع في الأُمور التي قد تنظر فيها.وذلك إِن كل صناعة إِنما هي
معلمة، أي مبرهنة، ومقنعة، في الجنس الذي تنظر فيه، لا في جميع
الأَجناس.مثال ذلك: إِن الطب إِنما يعلم على طريق البرهان ويقنع في الصحة
والمرض وفي أنواعهما، وكذلك الهندسة إِنما تعلم على طريق البرهان وعلى
طريق الإقناع في الأَعظام، والأَشكال التي توجد في الأَجسام.
وأما الخطابة فهي تتكلف الإِقناع في جميع الأَشياءِ: في أيّ مقولة كانت
وأيّ جنس كان.ولذلك ليس تنسب إِلى جنس خاص.
فأما الأَشياءُ التي تفعل التصديقات في هذه الصناعة: فمنها ما هي صناعية
وتلك هي التي وجودها إِلى اختيارنا ورويتنا ونحن الفاعلون لها، ومنها ما
هي غير صناعية وهي التي ليس وجودها لاختيارنا ورويتنا، مثل الشهود
والتعذيب والعقود وما أشبه ذلك مما سيذكر بعد.
والأَشياءُ الصناعية التي نحن الفاعلون لها: منها أشياء قد تقدم
غيرنا فصنعها، مثل الاحتجاج بالأَمثال السائرة التي قد وضعت واشتهرت،
ومنها ما نخترعها نحن عند القول في الشيء الذي فيه الإِقناع ونستنبطها.
فأما التصديقات التي نفعلها نحن ونخترعها فهي ثلاثة أنواع: أحدها إِثبات
المتكلم فضيلة نفسه التي يكون بها أهلا إِن يُصدق، كما قال تعالى حاكيا عن
هود: " وأنا لكم ناصحا أمين " ، وأن يكون عند التكلم بهيئة في وجهه
وأعضائه شأْنها إِن توقع التصديق بالشيء المتكلم فيه، مثل التؤدة والوقار
وغير ذلك.والفضيلة التي شأْنها هذا هي التي يعني أرسطو بالكيفية والهيئة
التي شأْنها هذا هو الذي يعني بالسمت.وقد يدل على إِن الفضيلة لها تأْثير
في التصديق إِن الصالحين الفاضلين يُصدقون سريعا دون قول يتكلفونه في
الشيءِ.وإنما يكون ذلك في الأُمور الظاهرة للحس التي يزعمون أنهم أحسوها،
مثل أنه شرب أو قتل.فأما إِخبارهم عن الأُمور الخفية عند الحس وهي التي
يظن أنه خفى عنهم ما أحسوا من ذلك أو وهموا فيه، إِذا كان ذلك الشيء ممكنا
إِن يهم فيه الحس، فليس يُصدّقون في الأَشياءِ التي يدعونها في أمثال هذه
الأَشياء دون إِن يستعملوا، في تثبيت ذلك الشيء، القولَ.
قال: وليس كما ظن الذين ذكرنا أنهم تكلموا في الخطابة إِن الفضيلة
والأَناة أنما هي نافعة في باب الإِنفعال فقط.
وأما الصنف الثاني من التصديقات فهو الصنف الذي يكون بأن يكسب السامع
بالقول إِنفعالا ما يوجب له التصديق بالشيءِ الذي فيه القول، فإِنه ليس
تصديقنا بالشيءِ وإِقرارنا به ونحن في حال الفرح أو الحزن تصديقا واحدا،
وكذلك إِذا كنا في حالة السخط على الشيء أو في حال الرضا عنه.وهذه هي
الأَشياءُ التي تكلم فيها أُؤلئك الذين ذكرنا أنهم تكلموا في هذه الصناعة.
وأما الصنف الثالث من هذه التصديقات فهو تثبيت الشيء بالكلام المقنع، أو
ما يظن به أنه مقنع، وذلك في الأُمور الجزئية التي تقنع فيها هذه
الصناعة.وإِذا كانت التصديقات إِنما تكون في هذه الصناعة بهذه الوجوه، فهو
بيّن إِن الذي يقدر إِن يقنع الإِقناع الممكن في كل واحد من الأَشياءِ
إِنما هو الذي يكون عالما بثلاثة أشياء، أولها: معرفة الأَقاويل المقنعة،
وثانيها: معرفة الأَخلاق والفضائل، وثالثها: معرفة الانفعالات، وذلك بأن
يعرف كل واحد من الانفعالات: ما هو، ومن أي شيء يكون، ومتى يكون، وكيف
يكون.وإِذا كان ذلك كذلك، فهذه الصناعة كأنها مركبة من صناعة الكلام
والصناعة الخلقية، أعني المدنية.وإِنما لم يوجد لمن تقدم قول مستوفي في
أجزائها إِما من قبل جهلهم، وإِما من قبل أنهم ضنوا على غيرهم وبخلوا
عليهم بما وقفوا عليه من ذلك لمكان الخيرات التي من خارج.
فهذه الصناعة هي جزء من صناعة المنطق، وهي شبيهة بالجدل في أ،ها تنظر في
كلا المتقابلين، وفي أنهما ليسا ينظران في شيءِ محدود نظرًا يبلغان به
اليقين، لكن إِنما يبلغان من النظر ما دون اليقين.وقد تكلم في ذلك فيما
كافيا.
وينبغي إِن نبتدئ بتعريف الأَقاويل المقنعة وما يرى أنه مقنع،
فنقول: إِن الأَقاويل التي يكون بها الإِثبات والإِبطال كما أنها في صناعة
الجدل صنفان: أحدهما الاستقراءُ، وما يظن به أنه استقراء، والصنف الثاني
القياس، وما يظن به أنه قياس، كذلك الأَقاويل المثبتة في هذه الصناعة
والمبطلة صنفان: أحدهما شبيه بالاستقراءِ وهو المثال، والآخر شبيه بالقياس
وهو الضمير.والضمير الذي يظن به أنه ضمير وليس بضمير يشبه القياس الذي يظن
به هنالك أنه قياس وليس بقياس.وكذلك المثال الذي يظن به أنه مثال وليس
بمثال يشبه الاستقراء الذي يظن به أنه استقراءٌ وليس باستقراء.فالضمير هو
القياس الخطبي، والمثال هو الاستقراء الخطبي.والخطباءُ إِذا تُؤمل أمرهم
ظهر أنهم إِنما يفعلون جميع التصديقات التي تكون بالقول بهذين الصنفين،
أعني إِما بالمثال، وإِما بالضمير، وذلك أنهم يؤمون بفعلهم هذا إِن
يتشبهوا بالاستقراءِ والقياس.والذي يفعلون من ذلك إِنما يفعلونه بما هو
مثال في الحقيقة وضمير في الحقيقة أو بما يظن به أنه كذلك، وليس كذلك.وقد
تبين في كتاب القياس إِن كل تصديق فإِنه يكون بالقياس،وإِن الاستقراءَ
والمثال إِنما يفيدان التصديق بما فيهما من قوة القياس.فأما ما هو القياس،
وما الفصل بينه وبين البرهان، فإِنه قد قيل في كتاب الجدل.وقد تبين هنالك
أيضا الفرق بين القياس والاستقراء.
والاستقراءُ والمثال يشتركان في إِن كليهما يثبتان إِن هذا الشيء موجود
كذا، أو غير موجود كذا من أجل وجود ذلك الشيء أو لا وجوده في شبيهه.
والضمير والقياس يشتركان في إِن كليهما قول يوضع فيه شيء فيلزم عنه شيء
آخر.
وإِذا كان الأَمر هكذا، فهو بيّن إِن في كل واحد من هذين الجنسين من القول
نوعا خطبيا ونوعا جدليا ونوعا برهانيا ونوعا سوفسطائيا.فإِنه كما يوجد
الاستقراءُ والقياس في هذه الصنائع، كذلك يوجد في الخطابة المثال
والضمير.وإِنما تختلف في هذه الصنائع بجهة الاستعمال، أعني في صناعة
البرهان وصناعة الجدل.والقياس في الجدل أوثق من الاستقراء.والمثال في
الخطابة أقنع من الضمير؛ لأَن الضمير يتطرق إِليه العناد أكثر من تطرقه
إِلى المثال.وسبب هذا سنخبر به فيما بعد، وكذلك كيف نستعمل هذه الأَشياء.
فأما الآن فينبغي إِن نحدد هذين الطريقين من الإِقناع: أعني الضمير
والمثال، فنقول: المثال إِن القول المقنع إِما إِن يكون مقنعا لواحد من
الناس، أو لجماعة من الناس أو لأَكثر الناس.وأيضا منه ما يكون إِقناعه في
أمْرٍ كُلي، ومنه ما يكون في أمْرٍ جزئي.وكلا هذين منه ما يكون إِقناعه
بيناً بنفسه، ومنه ما يكون إِقناعه بغيره في الجزئيات ضربان أحدهما إِن
يقول القائل: إِن كذا إِنما هو كذا لموضع كذا، مثل قول القائل: إِن شراب
السكنجبين ينفع فلانا لأَنه محموم.وهذا هو الذي يسمى الضمير.والضرب الثاني
إِن يقول إِن كذا إِنما كان كذا لأَنه مثل كذا، مثل إِن يقول: إِن فلانا
ينتفع بشراب السكنجبين، لأَن فلانا انتفع به.وهذا هو الذي يسمى المثال.
والمقنعات التي هي مقنعة عند واحد من الناس فليس تستعملها هذه الصناعة،
لأَن ذلك غير متناه وغير معلوم عند المستعمل لها.
ولذلك ليست تستعمل هذه الصناعة من المقدمات المحمودة، أعني
المقبولة، ما كان مقبولا عند واحد من الناس، وتلك هي الآراء الحادثة للناس
عند الشروق والهوى، بل إِنما تستعمل المحمود عند الأَكثر أو الجميع على
مثل ما تستعمله صناعة الجدل.وإِذا كان الأَمر هكذا، فالذي يفترق به القياس
المستعمل في صناعة الجدل وفي صناعة البرهان من الضمير المستعمل في هذه
الصناعة إِن القياس يرتب الترتيب الذي يكون به القول منتجا بالضرورة.وأما
الضمير فإِنه ترتب مقدماته الترتيب الذي هو معتاد عند الجمهور إِن يقبل،
وذلك هو بخلاف الترتيب الصناعي.فإِن الناس يستريبون باللازم عن القول
الصناعي، ويرون إِن ذلك إِنما لزم من جهة الصناعة لا من جهة الأَمر في
نفسه.وأيضا فإِن الترتيب الصناعي يقتضي إِن يصرح فيه بجميع المقدمات
الضرورية في بيان ذلك المطلوب، والجمهور لا يستطيعون إِن يفهموا لزوم
النتيجة التي تلزم عن مقدمات كثيرة.وأيضا فإِنهم لا يباعدون بين النتيجة
والشيءِ الذي تلزم عنه النتيجة، أعني أنهم لا يصرحون في المقاييس
بالمقدمتين جميعا مع النتيجة، بل إِنما يأتون بمقدمة واحدة ثم يردفونها
بالنتيجة، مثل أنهم يقولون: هذا يدور بالليل فهو لص، ولا يقولون: وكل من
يدور بالليل فهو لص، وهي المقدمة الكبرى.وأيضا فإِن الضمائر لما كانت تصنع
في الأَكثر في الأُمور الممكنة، وذلك بيّن في الأُمور المشاورية، فإِنه
ليس يشير أحد على أحد بأمر ضروري الوجود ولا ممتنع الوجود، وكانت المقدمة
الكبرى في أمثال هذه المواد كاذبة بالجزءِ، لم يصرحوا بها في المقاييس
التي يستعملونها في هذه الصناعة لئلا يفطن لكذبها.وأيضا فلما كانت
المقاييس الجيدة الصنعة في هذه الصناعة إِنما هي أحد صنفين: إِما المقاييس
التي تؤلف من المقدمات البينة إِقناعها بنفسه، وإِما من مقدمات تتبين
مقدماتها بمقدمات أُخر تخلط بها، وإِلا لم يتبين حمدها،فقد يلحق ضرورة في
هذا الصنف الثاني إِن يَعْسر تأْليف المقدمات وترتيبها الترتيب الصناعي
لمكان كثرة المقدمات وطول الزمان الذي يصرح فيه بجميعها وترتب ترتيبا
صناعيا.وذلك شيء لا يساعد عليه الحكام بل يحملون المتكلم بين أيديهم إِن
يكون كلامه بسيطا غير متكلف فيه صنعة على عادة الجمهور.فإِنه متى كان
الكلام ليس على هذه الصفة، كان غير مقنع، وذلك في الأَمرين اللذين يكون
فيهما الإِقناع، أعني في إِن الشيء موجود أو غير موجود وفي أنه، إِذا وجد،
محمود أو غير محمود.وكذلك إِذا استعمل التصديق بطريق أخذ الأَشباه،
فاستقصى فجعلها على طريق الاستقراءِ، عرض العير الذي وصفناه من الطول
والكثرة.وإِذا كان هذا هكذا، فإِذن القياس الخطبي وهو الضمير والمثال
إِنما يكونان في الأَشياءِ التي يكون فيها القياس والاستقراءُ
بإِطلاق.وتلك الأَشياءُ مأْخوذة بحال غير الحال التي أخذت بها في القياس و
الإستقراءِ.فإِذا استعمل تلك الأَشياءُ بالحال التي بيّن في كتاب القياس،
عاد المثال استقراء، والضمير قياسا.وإِذا أخذت بهذه الحال التي ذكرنا، عاد
الاستقراءُ مثالا والقياس ضميرا.وتلك الحال هي أخذ القياس والاعتبار
بمقدمات قليلة وجيزة.فإِن الإِقناع إِنما يكون أكثر من ذلك بالمقدمات
القليلة الوجيزة، أو بالمقدمات التي هي في غاية الظهور وحذف ما خفي
منها.وأيضا فإِن المحمود في هذه الصناعة إِن يحذف اللازم عنه، ويؤتى
بالشيءِ الذي الذي يلزم، لأنه إِذا أخبر باللازم والملزوم فكأنه قد ذكر
الشيءَ مرتين، فيكون هزراً في بادئ الرأي.وعلى هذا فلا يصرح بالحد الأوسط
في القياس إِلا مرة واحدة، ولا في الاعتبار إِلا بشبيه واحد، فيكون القياس
ضرورة ضميرا أي محذوفا إِحدى مقدمتيه، وبهذا سمي ضميرا، إِذ كانت إِحداهما
مضمرة، ويكون اٌلإِستقراءُ ضرورة تمثيلا.
قال: ومقدمات القياسات الخطبية قد تكون ضرورية وذلك في الأَقل، وتكون
ممكنة وذلك في الأَكثر.لأَن أكثر الفحص الجمهوري إِنما هو فيما يمكن إِن
يكون بحال، ويمكن ألا يكون بتلك الحال.وذلك بيّن في الأَشياءِ التي يشار
بها، وذلك أنها كلها أمور مفعولة للإِنسان.وليس يمكن إِن تكون الأَشياءُ
المفعولة للإِنسان لا ضرورية الوجود ولا ممتنعة الوجود.والنتائج الضرورية
فإِنها تكون بالذات عن مقدمات ضرورية، والممكنة عن مقدمات ممكنة.
والضمائر منها ما يكون عن مقدمات محمودة، ومنها ما يكون من
الدلائل.وأعني بالمقدمات المحمودة التي ليست دلائل، مثل أنه ينبغي إِن
يشكر المنعم وأن يُساءَ إِلى المسيء.وأعني بالدلائل الأَشياءَ التي تدل
على وجود شيء لشيءٍ.وهذان الصنفان من المقدمات توجدفي المواد الضرورية
والممكنة، أعني المحمودات والدلائل، وليس توجد في الممكنة على الأَكثر
فقط، بل وفي الممكنة على التساوي وهي التي نسبتها إِلى المقدمات الممكنة
على الأَكثر نسبة التي على الأَكثر إِلى الضروري، وهي نسبة الكل من
البعض.وذلك إِن الصدق في الضرورية أعم من الصدق في الممكنة على الأَكثر،
إِذ كانت الضرورية توجد لكل الموضوع، والممكنة على الأَكثر لا توجد
لكله.وكذلك نسبة الممكنة على التساوي إِلى الممكنة على الأَكثر هي هذه
النسبة، أعني إِن الممكنة على الأَكثر تصدق في موضوعاتها على اكثر مما
تصدق الممكنة على التساوي.
والدلائل المأخوذة حداً أوسط: منها ما هو أعم من الطرف الأَصغر وأخص من
الأَكبر، ومنها ما هو أعم من الطرفين، ومنها ما هو أخص منهما.
أما الذي هو أعم من الطرف الأَصغر وأخص من الأَكبر فإِنه يأْتلف ضرورة في
الشكل الأَول.وإِذا كان في المادة الممكنة على الأَكثر فهو الذي يعرفه
القدماء بالأَشبه.ومثاله في المادة الضرورية: هذه المرأة لها لبن فهي قد
ولدت.وفي الممكنة على الأَكثر: فلان يعد السلاح ويجمع الرجال وليس قربه
عدو، فهو يريد إِن يعصى الملك.ومثال الممكنة على التساوي: فلان قد تعب،
والمتعوب محموم، ففلان محموم.وهذا هو الذي يعرف بالمشبه.
وأما ما هو أعم من الطرفين فإِنه يأْتلف في الشكل الثاني إِلا أنه غير
منتج إِلا في بادئ الرأي.مثال ذلك في المادة الممكنة على الأَكثر قول
القائل: سقراط يتنفس متواترا، والمحموم يتنفس متواترا، فسقراط
محموم.فهاتان المقدمتان صادقتان، والنتيجة قد تكون كاذبة، إِذ قد يمكن إِن
يتنفس سقراط متواترا لموضع إِحضاره.ولما كان ذلك خافيا على كثير من الناس،
إِذا رأوا في أمثال هذه المقدمات الصادقة أنها تنتج كذبا، ظنوا لذلك أنه
قد انطوى فيها كذب، فيرومون إِن يعاندوا المقدمات، فيعسر ذلك عليهم لمكان
صدقها، فيتحيرون لذلك.
وأما التي هي أخص من الطرفين فتنتج في الشكل الثالث جزئيا لا كليا، لكن
تؤخذ نتيجته في هذه الصناعة كلية.مثال ذلك في المادة الضرورية قول القائل:
الأَشياء كلها في كرة العالم، والأَشياءُ كلها في الزمان، فالزمان كرة
العالم.وفي الممكنة قول القائل: الحكماءُ عدول، لأن سقراط حكيم وعدل.
والدلائل التي تكون في الشكل الثالث والثاني تخص باسم العلامة، وما كان
منها في الشكل الأَول يخص باسم الدليل.والذي في الشكل الثاني هو أخص باسم
العلامة من الثالث.كما أنه ما كان من ذلك في الممكنة الأَكثرية يخص
الأَشبه، وإِن كان في الممكنة على التساوي خص باسم الضمير المشتبه.
فقد تبين من هذا القول ما هي المحمودات والدلائل والعلامات، وما الفرق
بينهما.لكن الذي تبين من الأَقاويل القياسية على الحقيقة إِنما هو في كتاب
القياس، وتبين في جنس جنس منها ما هو قياس وما ليس بقياس.
وأما المثال فقد بينا في ما تقدم أنه استقراء ما، لكن يباين
الاستقراء بأنه ليس يصار فيه لا من الجزئي إِلى بيان الأَمر الكلي كما
يصار في بعض أنواع الاستقراء، ولا من الكلي إِلى الجزئي كما قد يصار في
بعض أنواع الاستقراءِ، وذلك إِذا بينا بالكلي الذي أثبتناه بالاستقراءِ
جزئيا آخر غير الجزئيات التي أثبتنا الكلي باستقرائها؛ ويوافقه في أنه
يصير من جزئي إلى جزئي لاجتماعها في أمر كلي، وذلك إِذا جمعنا في
الاستقراءِ الأَمرين جميعا،أعني إِن نصير فيه من الجزئي إِلى الكلي، ثم من
الكلي إِلى جزئي آخر، فإِنا في هذا الفعل قد صرنا من جزئي إِلى جزئي بتوسط
الكلي، كالحال في المثال.فإِن المثال إِنما نصير فيه من جزئي إِلى جزئي
لاشتراكهما في أمر كلي،إِذا كان الحكم المنقول من أحدهما إِلى الآخر
موجودا للجزئي الأَعرف من أجل ذلك الكلي أوْ يظن به أنه يوجد له من جهته،
وإِلا لم تصح النُّقلة من جزئي إِلى جزئي، أعني إِن لم يكن هنالك كلي،
وكان وجود ذلك الحكم من أجله للجزئي الأَعرف.ومثال ما يعرض من هذا في
الاستقراءِ، أعني إِذا كانت النقلة من جزئي إِلى جزئي بتوسط النقلة إِلى
الكلي، قول من قال: أيها الملك، إِن فلانا طلب إِن يكون في جملة العسس،
وقد كان في جملة عدوك، فلا تبح له ذلك، فإِنه يريد إِن يفتك بالملك، لأن
فلانا طلب ذلك من فلان الملك، وفلانا من فلان الملك، لأَقوام يعددهم،
ففتكوا بملوكهم.فإِنَّ قائلَ هذا القول قد جعل النقلة فيه من جزئي إِلى
جزئي بتوسط الكلي الذي هو إِن كل من طلب إِن يدخل في الحرس ممن كان في
جملة عدو الملك فهو يريد إِن يفتك به.إِلا إِن هذا الكلي الذي ارتسم في
النفس بالقوة، وإِن لم يصرح به، يستعمل النقلة من جزئي إِلى جزئي، إِذا
كانت النقلة إِليه في الذهن من أكثر الجزئيات، كان استقراء، وإِن كان من
واحد منها، أو من الأَقل، كان تمثيلا.
قال: فأما القول في هذه الأَشياء التي يقال لها مثالات، فقد يكتفي هاهنا
بهذا المقدار المعطى منها.
وأما القول في فصول الضمائر من جهة الأَشياءِ التي منها تعمل، فإِن القول
فيها غامض وخفي وهو عظيم الغناءِ فيما نقصده هاهنا.وسبب غموضه إِن الضمائر
تكون في جميع المقولات العشر كما تكون القياسات الجدلية.لكن من الضمائر ما
يكون في المواد التي في الصنائع مثل الضمائر التي تستعمل في الأُمور
الكلية والجزئية في صناعة الطب وغيرها من الصنائع.وهذه فينبغي إِن تستعمل
في هذه الصنائع على نحو استعمال البراهين في تلك الصناعة، لا على نحو ما
يستعملها الخطيب في المادة التي تخص الخطابة، مثل إِن يأْتي بها جزءَا من
خطبة وسائر الأَشياءِ التي تكون بها الأَقاويل الخطبية أتم فعلا وأنفذ مما
يذكر بعد.ومن الضمائر ما يكون في الأُمور التي تخص هذه الصناعة بحسب ما
تبين من منفعتها وهي الأُمور الإِرادية،وهذه هي التي ينبغي إِن تستعمل على
جهة ما يستعمل الخطباءُ الأَقاويل الخطبية.ومن هذه الأَشياءِ ينبغي إِن
تعدد في هذه الصناعة الأَشياء التي هي فصول الضمائر لا من تلك المواد التي
تحتوي عليها صناعة صناعة.
قال: وكلما كان القول أكثر عموما، كان أكثر مؤاتاه وتأتيا لأَن يستعمل في
أشياء كثيرة.وكلما كان أقل عموما، كان أحرى إِن يكون جزءاًمن صناعة
مخصوصة.ولذلك كانت المواضع أعم من القياسات الخطبية والقياسات
الجدلية.وذلك إِن المواضع توجد تعم الأُمور المنطقية والطبيعية والسياسية،
أعني الإِرادية، وذلك مثل مواضع الأَقل والأَكثر التي عددت في الثانية من
كتاب الجدل.وذلك إِن هذه المواضع ليس تعمل منها المقاييس في صناعة واحدة
من هذه الثلاث التي ذكرنا، بل في جميعها، إِذ كانت لا تستعمل نفسها وإِنما
تستعمل قوتها.
وأما الأَنواع فهي المقدمات الخاصة بصناعة صناعة من الصنائع الجزئية، مثل
المقدمات التي تعمل منها المقاييس في الأُمور الطبيعية، فإِنها لا تعمل
منها المقاييس في الأُمور الخلقية، ولا التي في الخلقية تعمل منها
المقاييس في الأُمور الطبيعية.
وإِذا كان الأَمر هكذا، فإِذن المواضع لا يؤلف منها قياس في
صناعة مخصوصة، إِذ ما يتصور منها هو عام لأَكثر من صناعة واحدة.وأما
الأَنواع فهي التي تؤلف منها المقاييس التي تلتئم منها الصناعة التي تلك
الأَنواع مخصوصة بها.لكن الأَنواع التي نحن عازمون في هذا الكتاب على
ذكرها ليست هي مقدمات يقينية، لأَنه لو كان ذلك كذلك لكانت المقاييس
الخطبية مقاييس يقينية ولم تكن مقاييس جدلية فضلا عن خطبية.والضمائر
المعمولة في هذه الصناعة أكثر ذلك إِنما تؤلف من هذه الأَنواع ماكان منها
خاصا بجنس جنس من أجناس الخطابة الثلاثة وماكان منها عاما للأَجناس
الثلاثة التي تحدد بعد.
قال: وقد يجب إِن يفعل هاهنا في هذه الأَشياءِ مثل ما فعل في كتاب
الجدل.فكما إِن ما ذكر هنالك من مواد الأُمور الجدلية قسمت إِلى مواضع
وأنواع، كذلك يجب إِن تقسم هاهنا الأُمور التي تعمل منها الضمائر إِلى
مواضع وأنواع.والأَنواع: هي المقدمات الكلية التي تستعمل في صناعة صناعة.
والمواضع: هي المقدمات الكلية التي تستعمل جزئياتها في صناعة صناعة.فيجب
إِن يقال أولاً في الأَنواع، ثم من بعد ذلك في المواضع.وذلك بأن نبدأ
أولاً فنحد أجناس الأَشياء الخاصة بهذه الصناعة، أعني أجناس موضوعات هذه
الصناعةالخاصة بها.فإِذا حددناها، أخذنا حينئذ في تعديد اسطقساتها
ومقدماتها على حدة.
وقد توجد أجناس الأَشياءِ التي تنظر فيها الخطابة من الأُمور الإِرادية
ثلاثة، كما يوجد عدد أصناف السامعين للقول الخطبي ثلاثة.وذلك إِن الكلام
مركب من ثلاثة: من قائل وهو الخطيب؛ ومن مقول فيه وهو الذي يعمل فيه
القول؛ ومن الذين يوجه إِليهم القول وهم السامعون.والغاية بالقول إِنما هي
متوجهة نحو هؤلاءِ السامعين.والسامعون لا محالة: إِما مناظر، وإِما حاكم،
وإِما المقصود إِقناعه.والحاكم: أما إِن يكون حاكما في الأُمور المستقبلة،
وهي النافعة والضارة، وإِما في الأُمور التي قد كانت.والأُمور التي قد
كانت: منها ما توجد في الإِنسان باختياره، وتلك هي الفضائل والرذائل،
ومنها ما توجد في الإِنسان بغير اختياره، بل من إِنسان آخر، وهو الجور
والعدل.والحاكم في الأُمور المستقبلة هو الرئيس، والحاكم في الأُمور
الكائنة هو الذي ينصبه الرئيس، مثل القاضي في مدننا هذه، وهي مدن
الإِسلام.وأما المناظر فإِنما يناظر بقوة الملكة الخطبية.فإِذن أجناس
القول للخطبي ثلاثة: مشوري ومشاجري وتثبيتي.فأما الضمير المشوري: فمنه
إِذْن، ومنه منع؛ وذلك إِن كل من يشير إما على واحد من أهل المدينة بما
يخصه، أو على جميع أهل المدينة بما يعمهم، فإِنما يشير أبدا بقول هو إذن
أو منع.وأما القول المشاجري فهو أيضا صنفان: شكاية وتنصل من الشكاية.وأما
القول التثبيتي فهو أيضا صنفان: إما مدح، وإما ذم.والزمان الخاص
بالأَشياءِ التي يشار بها هو الزمان المستقبل، لأَنه إِنما يشير إِنسان
على إِنسان بأشياءِ معدومة.والزمان الخاص بالأَشياءِ المشاجرية هو الزمان
الماضي، لأَنه إنما يتشكى من الأَشياءِ التي قد وقعت.وإِن تشكى من أُمور
تتوقع من المشتكى به، فإِنما تلك شكاية على طريق الإِشارة بالنافع في
ذلك.وكذلك قد يعرض إِن تكون المشورة في الأَشياِء التي قد كانت، لكن من
جهة ما يتوقع منها.فمتى كانت الشكوى في شىء واحد، لا من أجل غيره، فإِنما
تكون أبدا في الشيءِ الذي قد وقع.وأما الأَشياءُ التثبيتية: فإِن أوْلَى
الأَزمنة بها هو الزمان الحاضر، أعني القريب من الآن.فإِن الناس إِنما
يمدحون ويذمون بالأَشياءِ الموجودة في حين المدح وحين الذم في الممدوح
والمذموم.وربما مدح بعضهم على طريق الحيلة في استكثار فضائل الممدوح أو
مذامّه بالأَشياءِ التي يتوقع حدوثها منه، أو يرجى حدوثها منه، فيخلطون مع
المدح الإِشارة على الممدوح بفعل تلك الأَشياءِ.
وأما الغايات من هذه الأَقاويل فهي ثلاث غايات لهذه الثلاثة
الأَقاويل.أما القول المشير فغايته النافع والضار.فإِن الذي يشير، فإِنما
يأْذن في النافع أو في الذي هو أنفع، ويمنع من الضار أو من الذي هو
أضر.وأما القول المشاجري فغايته العدل والجور.وأما القول المثبت فغايته
الفضيلة والرذيلة.وإن استعمل واحد من هذه غاية صاحبه، فليس على القصْد
الأَول، بل من أجل الغاية الخاصة به.مثال ذلك إِن المشير قد يقنع إِن هذا
عدل أو جور، ليشير بالإِذن فيما يكون عن العدل من المنفعة، وبالمنع عما
يكون على طريق الجور لما في الجور من المضرة التي تتوقع.وكذلك قد تستعمل
الفضيلة والرذيلة، أعني من جهة ما يلحقها من النافع والضار.
وإِذا كانت هذه الغايات الثلاث تخص كل منها واحداً من هذه الأَقاويل، أعني
من جهة ما هي غايات على القصْد الأَول، فالحدود المميزة لكل واحد من هذه
الأَقاويل الثلاثة إنما تكون الفصول المعطاة فيها من قبل هذه الغايات.وقد
يدل على إِن هذه الغايات هي خاصة بواحد واحد من هذه الأَجناس الثلاثة من
الأَقاويل أنه إذا أقنع كل واحد منها في غاية الجنس الآخر، ربما لم يكن
للمناظر في ذلك معاسرة ومشاكسة، بل كثيراً ء ما يسلم له ذلك، ولكن لا يسلم
له غاية ذلك القول التي تخصه.مثال ذلك إِن المدعي إذا ادعى إِن فلانا أخذ
المال من فلان، وذلك لا شك ضرر به، فربما يسلم له الخصم إِن ذلك كان، ولكن
لا يسلم له إِن أخذه المال منه كان على جهة الجور.وكذلك المشير قد يسلم
إِن الفعل الممكن جور، ولا يسلم أنه ضارٌ.ولمكان تداخل هذه الغايات يعرض
للمشيرين كثيراً إِن يشيروا بأشياء ضارة على جهة المغالطة من قِبَل أنها
عدل أو أنها ليست بجور، ولكن لا يقرون بأنها ضارة، بل ربما أحتالوا في
دعوى وجود النفع فيها.مثال ذلك أنهم قد يشيرون بالصبر على الموت في الحرب،
وألا يفروا، لكوْن الفرار جوراً في الشريعة.وكذلك متى قهر قوماً واستولوا
عليهم، ربما أشار المشير عليهم ألا يمتعضوا لذلك القهر لأَنه لم يكن
جوراً، وربما أوهم فيه أنه غير ضار لهم.وكذلك المادح قد يسلم إِن الشيءَ
ضار، ولكن يدعى أنه فضيلة، مثل من يخلص إِنسانا من الموت ويعلم أنه يموت
بتخليصه ذلك الإِنسان.فالموت يسلم الخصم أنه ضار، ولكن يرى أنه فضيلة.كذلك
ربما مدح بالرذيلة على جهة المغالطة من جهة أنها نافعة، لكن لا يقر أنها
رذيلة.بل يدعي فيها أنها فضيلة ما لمكان النفع الذي فيها.فإِذن كل واحدة
من هذه المخاطبات قد تستعمل غاية صاحبتها بالعرض ولذلك لا يشاكس فيها،
ويشاكس و لا بد في غايتها.وإِذا استعملت الواحدة غاية صاحبتها فعلى جهة
المغالطة.
قال: ولما كانت هذه الصناعة قياسية، فمعلوم أنه يجب إِن تكون فيها مقدمات،
ومقدماتها هي الثلاث التي وصفنا: المحمودات والدلائل والعلامات.وذلك إِن
القياس المطلق يكون من المقدمات المطلقة.والقياس الخاص بصناعة صناعة يكون
من مقدمات خاصة.ولذلك كان الضمير قياساً يأْتلف من هذه المقدمات التي
ذكرنا.ولأَن الأَمر الذي يشير به يحتاج إِن يعرف من أمره أولاً أنه ممكن،
لأَن الأُمور الغير ممكنة لا يستطاع إِن تفعل لا في الحاضر ولا في
المستقبل.وكذلك يحتاج في الجنسين الباقيين من أجناس هذه الصناعة، أعني إِن
نبين أولا إِن الأَمر قد كان وقع، أعني الجنس التثبيتي والجنس
المشاجري.فإِذن لا بد لصاحب هذه الصناعة إِن تكون عنده مقدمات يقنع بها في
إِن الأَمر ممكن أو غير ممكن، وفي أنه قد كان أو لم يكن، سوى المقدمات
التي يبين بها تلك الغايات الثلاث.ثم أيْضا لما كان الخطباءُ ليس يقتصرون
على المدح والذم والإِذن والمنع والشكاية والإِعتذار، بل يتكلفون مع هذا
إِن يثبتوا إِن الأَمر - الذي هو خير أو شر - عظيم أو صغير، شريف أو خسيس،
ولائق أو غير لائق، وذلك إِما على الإِطلاق وإِما بالمقايسة، أعني أنه
أعظم وأشرف، أو بالضد، فمعللوم أنه ينبغي إِن تكون عند الخطباءِ مقدمات
يثبتون بها إِن الخير أو الشر عظيم أوْ صغير، و خسيس أوْ شريف، ولائق
بالمنسوب إِليه أو غير لائق.فهذه هي جميع أنواع المقدمات التي تستعملها
هذه الصناعة.
وإِذ قد تبين ذلك فينبغي إِن نبتدئ بتعديد المقدمات التي تخص
غرضا غرضا من الأَغراض الثلاثة ونجعل الكلام أولا في تعديد المقدمات
المشورية، ثم ثانيا في التثبيتية، ثم ثالثا في المشاجرية.
فأول ما يجب إِن ننظر فيه من أمر الأَشياءِ التي يشار بها ما هو الخير
الذي يشار به.فإِنه ليس تكون المشورة في كل خير، لكن في الخيرات التني
تستطيع إِن تكون أو إِن لا تكون.فأما الخيرات التي كونها أو لا كونها من
الاضطرار، فليس تكون فيها مشورة.ولا أيضا المشورة تكون في جميع الخيرات
الممكنة، فإِن هاهنا خيرات ممكنة وجودها عن الطبيعة، بل في الخيرات
الممكنة التي إِلينا إِن تكون أو إِن لا تكون، وهي الأَشياءُ التي التي
بدءُ كونها من قبل الاختيار والإِرادة.ومن هذه فيما كان وجوده أو لا وجوده
تابعا لرويتنا وأفعالنا على الأَكثر.وأما ما كان منها يعرض عن الروية
بالاتفاق وأقل ذلك، فليست هي في الأَكثر مما يشار بها، إِلا حيث لا يمكن
إِن يوجد الجنس الآخر.وقد يدل على إِن االإِشارة إِنما تكون بهذه
الأَشياءِ إِن الإِنسان إِنما ينظر أولاً هل الأَمْرُ الذي يريد إِن يفعله
ممكن أو غير ممكن، ثم إِن كان ممكناً، بأي شيءٍ يمكن وكيف يمكن.فإِذا تبين
له ذلك، شرع في السعي فيه.وإِن تبين له أنه غير ممكن، خلا عنه.والأَشياءُ
التي بها نشير هي التي فيها نروى.فقد تبين من هذا القول ما هو الخير الذي
نشبر به وفي أي الأَشياءِ يكون، وهي الأُمور الإِرادية التي مبدأ وجودها
منا، لا الأُمر الاضطراراية التي ليس إِلينا وجودها.وإِعطاء الفرق التام
بين الأَشياءِ الإِرادية وغير الإِرادية وتصحيح عدد أنواعها ومعرفة ماهية
كل واحد منها على أقصى ما في طباعها إِن تعلم فليس من شأن هذه الصناعة إِن
تبلغه من معرفة الأَشياءِ الإِرادية، ولكن ذلك من شأْن صناعة الفلسفة التي
لها الفضل على هذه في التصور والتصديق، والمقدمات المستعملة فيها أصدق
وأصح من هذه.وذلك إِن هنا لسنا نتكلف من معرفة هذه الأَشياء الأَحوال
الذاتية المناسبة لها، بل الأُمور المشهورة.وإِذا كان الأَمر في هذه
الأَشياء كما وصفنا، فقد تبين أيضا من هذا القول إِن جميع ما قلناه في
أجزاءِ هذه الصناعة هو حق، أعني أنها مركبة من علم المنطق ومن علم السياسة
الخلقية وأن فيها أشياء جدلية أو شبيهة بالأَشياء الجدلية وأيضا سوفسطائية
أو شبيهة بالسوفسطائية.والأَشياءُ التي في صنائع كثيرة إِنما تكون أجزاء
أجزاء لصناعة واحدة متى أخذ جميعها بالجهة والحال التي تكون بها تلك
الأَشياءُ الكثيرة متعاونة ونافعة في غرض تلك الصناعة الواحدة، وطرح منها
الأَحوال التي بها تختلف، أعني الأَشياء التي ليست تكون بها مغنية في غرض
تلك الصناعة الواحدة.وإِذا كان ذلك كذلك، فالأَشياءُ الخلقية إِنما صارت
جزءًا من هذه الصناعة من حيث هي معدة نحو الكلام والمخاطبة، وهي من صناعة
السياسة من حيث هي أحد الموجودات التي نقصد معرفتها وعلمها.والأَشياءُ
الجدلية والسوفسطائية إِنما صارت جزءًا من هذه الصناعة من حيث إِن الذي
تستعمل منها هذه الصناعة هو سابق المعرفة الأُولى للإِنسان، لا ما هو بعيد
عن معرفة الجمهور، مثلأنها إِنما تستعمل من القياس القياس المعروف عند
الجمهور وهو التمثيل والضمير.وكذلك الحال في الأُمور السوفسطائية إِنما
تستعمل منها ما جرت العادة باستعماله عند الجمهور، مثل مواضع الإِطلاق
والتقييد وغير ذلك مما يستعمله بطباعهم الجمهور.فهي إِنما تخالف هذه
بمقدار النظر.وقد تخالف أيضا بمقدار النظر هذه الصناعة في الأُمور
الإِرادية النظر الذي للعلم السياسي فيها، أعني أنها إِنما تنظر في
الأُمور الإِرادية النظر الذي هو في سابق المعرفة للإِنسان وتدع تقصي
النظر في ذلك للعلم السياسي.
والأُمور التي يشير بها الخطيب منها ما يشير به على أهل مدينة بأسرهم،
ومنها ما يشير به على واحد من أهل تلك المدينة أو جماعة.فأما الأَشياءُ
التي تكون فيها المشورة في الأُمور العظام من أمور المدن فهي قريبة من إِن
تكون خمسة: أحدها الإِشارة بالعدة المدخرة من الأَموال بللمدينة.والثاني:
الإِشارة بالحرب أو السلم.والثالث الإِشارة بحفظ الثغر مما يرد عليه من
خارج.والرابع الإِشارة بما يدخل في البلد ويخرج عنه.والخامس الإِشارة
بالتزام السنن.
فالذي يشير بالعدة يحتاج إِن يعرف ثلاثة أمور: احدها إِن يعرف
غلات المدينة ما هي، أعني هل هي نبات أو حيوان أو معدن أو جميع هذا أو
اثنان، كيما إِن نقص من الفاضل منها للعدة شيء أشار بالزيادة.والثاني إِن
يعرف مع ذلك نفقات أهل المدينة كلها.والثالث إِن يعرف أصناف الناس الذين
في المدينة.فإن كان فيها إنسان بطال وهو الذي لا فضيلة عنده، أو عاطل وهو
الذي لا صناعة له، أشار بتنحيته من البلد.وإِن كان هنالك عظيم النفقات في
غير الجميل أو غير الضروري أشار بأخذ ذلك الفضل من المال منه.فإِنه ليس
يكون الغنى بالزيادة في المال، بل وبالنقصان من النفقة.ولذلك قيل: قلة
العيال أحد اليسارين.
قال: ومن الضرورة الداعية إلى هذه الأَشياء ومقدار الحاجة إليها يقف
الخطيب على ما يحتاج إِن يشير به في واحد واحد من هذه الأَشياء.وليس يحتاج
عند الإِشارة بالزيادة في النبات إِن يكون فلاحا، ولا في الحيوان إِن يكون
راعيا، لكن يكفيه في ذلك معرفته بمقدار الحاجة إليها.لكن يحتاج مع هذا إِن
يكون عالما بالسير المتقدمة في هذه الأَشياءِ وما عند الناس فيها.
وأما المشير بالحرب أو السلم فإِنه يحتاج إِن يعرف قوة من يحارب ومقدار
الأَمر الذي ينال بالمحاربة هل هو يسير أو عظيم، وحال المدينة في وثاقتها
وحصانتها، وضعف أهلها وقوتهم، وفي صغر المدينة وعظمها، أعني هل مقدارهم
مقدار من يستطيع المحاربة أم ليس مقدارهم ذلك المقدار، وهل هم بصفة من
تمكنهم المحاربة أم ليس هم، وأن يعرف مع ذلك شيئا من الحروب المتقدمة ليصف
لهم كيف يحاربون إِن أشار عليهم بالحرب ويهون عليهم أمر الحرب، أو يعرفهم
بما في الحرب من مكروه إِن أشار عليهم بترك الحرب.وقد يحتاج إِن يعرف ليس
حال أهل مدينته فقط، بل وحال من في تخومه وثغره، أعني كيف حالهم في هذه
الأَشياءِ وحالهم مع عدوهم في الظفر به أو العجز عنه.فإِنه يأخذ من هاهنا
مقدمات نافعة في الإِشارة عليهم بالحرب أو السلم.ويحتاج مع هذا إِن يعلم
الحروب الجميلة من الحروب الجائرة وأن يعلم حال الأَجناد هل هم متشابهون
في القوة والشجاعة والرأْى وإِجادة ما فوض إِلى صنف صنف منهم من القيام
بجزء جزء من أَجزاءِ الحرب، أعني إِن يكونوا في ذلك متشابهين، فإِنه ربما
كثروا وتناسلوا حتى يكون فيهم من لا يصلح للحرب أو للجزءِ من الحرب الذي
فوض إِليه القيام به.وقد ينبغي مع هذا إِن يكون ناظرا ليس فيما أفضت إِليه
محاربتهم بل وفيما أفضت إِليه حروب سائر الناس من المتقدمين المشابهين
لهم، فإِن الشبيه يحكم منه على الشبيه، أعني أنه إِن كان أفضت الحروب
الشبيهة بحربهم إلى مكروه إِن يشير بالسلم، وإِن كانت أفضت إِلى الظفر إِن
يشير بالحرب.
وأما حفظ البلاد فإِنه يحتاج المشير بالحفظ، إِن يعرف، كيف تحفظ البلاد،
ومامقدار الحفظ المحتاج إِليه في طارئ، وكم أنواع الحفظ ويعرف مع هذا
المواضعَ التي يكون حفظها بالرجال وهي التي تسمى المسالح.فإِن كان الحفظة
لتلك المواضع قليلا، زاد فيهم.وإِن كان فيهم من لا يصلح للحفظ، نحاه، ممن
ليس يقصد قصد المحاماة عن المدينة، بل يقصد قصد نفسه.وينبغي له إِن يحفظ
أكثر ذلك المواضع الخفية، أعني التي المنفعة بحفظها أكثر.فمن عرف هذا فقد
يمكنه إِن يشير بالحفظ وأن يكون خبيرا بالبلاد التي يشير بحفظها.
وأما الإِشارة بالقوت وسائر الأَشياءِ الضرورية التي تحتاجها المدينة
فإِنه يحتاج المشير فيه إِن يعرف مقدارها، وكم يكفي المدينة منها، وكم
الحاضر الموجود في المدينة من ذلك وهل أدخل الكافي من ذلك في المدينة
وأحرز أم لم يدخل، وما الأَشياءُ التي ينبغي إِن تخرج من المدينة وهو
الفاضل عن أهل المدينة.وما الأَشياءِ التي ينبغي إِن تدخل وهو ما قصر عن
الضروري، لتكون مشورته وما يعهد به على حسب ذلك.فإِنه قد يحتاج المرءُ إِن
يحفظ أهل مدينته لأَمرين: أحدهما لمكان ذوي الفضائل، والثاني لمكان ذوي
المال اللذين هم من أجل ذوي الفضائل.والحافظ للمدن يحتاج بالجملة إِلى إِن
يكون عارفا بجميع هذه الأَنواع الخمسة عند حفظه لها.
قال: وأما النظر في وضع السنن والإِشارة بها فليس بيسير في أمر
المدن.فإِن المدن إِنما تسلم ويلتئم وجودها بالسنن.ولذلك قد ينبغي لواضع
السنن إِن يعرف كم أصناف السياسات وأي سُنة تنفع في سياسة وأي سُنة لا
تنفع وأي ناس تصلح بهم سُنة سُنة وسياسة سياسة وأي ناس لا تصلح بهم، وأن
يكون يعرف الأَشياءَ التي يخاف إِن يدخل منها الفساد على المدينة وذلك
إِما من الأَضداد من خارج، وإِما من أهل المدينة.فإِن سائر المدن، ما عدا
المدينة الفاضلة، قد تفسد من قبل السنن الموضوعة فيها، وذلك إِذا كانت
السنة مفرطة الضغف واللين أو مفرطة الشدة وسواء كانت في رأْي أو في خلق أو
في فعل.وذلك إِن السياسة التي تسمى الحرية قد يظهر من أمرها أنها تنتقل
كثيرا من قبل هذا المعنى إِى رياسة الخسة، أعني رياسة الشهوات أو رياسة
المال.والذي قاله ظاهر عندنا من أمر السياسات التي وصلتنا أخبارهم.
قال: وليس يؤول الأَمر في هذه السياسة، أعني سياسة الحرية، إِلى سياسة
الأَخساء من قبل استرخاءِ السنن ولينها، وإِن كان ذلك هو الأَكثر، بل ومن
قبل الإِفراط.فإِن كثيرا من الأَشياءِ إِذا أفرطت بطل وجودها، كما يبطل
وجودها من قبل الضعف والتقصير.ومثال ذلك: إِن الفطس إِذا أفرط وتفاقم، كان
قريبا من إِن يظن أنه ليس هنالك أنف.وإِذا كان غير مفرط، قرب من الاعتدال.
قال: ويحتاج مع ذلك إِن يعرف السنن التي وضعها كثير من الناس فانتفعوا بها
في سياسة سياسة من السياسات المشهورة وفي أمة أمة ليستعمل منها النافع
الذي يخصه والأُمة التي تخصه.ولذلك يتبين إِن معرفة واضع السنن بأمزجة
الناس وأخلاقهم وعاداتهم مما ينتفع به في وضع السنن.فإِن من هاهنا يمكن
إِن يضع السنن النافعة لجميع الأُمم المختلفة الطبائع.وأما الفساد الداخل
على المدن من خارج، أعني من الأَعداءِ، فأمر ظاهر بنفسه، وقد كتب الناس في
الأَوجه التي يتوقع منها غلبة الأَعداءِ، والأَوجه التي يتحرز بها
منهم.ومن هذه الأَشياءِ يأخذ المقدمات التي يشير بها على أهل مدينته
بالتحفظ من الأَعداءِ.وما قلنا في وضع السنن وما يحتاج إِليه واضعها هو من
علم السياسة، لا من علم الخطابة.وإِنما يذكر منها هاهنا ما يكفي في هذه
الصناعة.
قال: فهذه هي الأُمور العظمى التي بها يشير المشيرون على أهل المدن، وفيها
دلالة على الأَشياءِ التي منها يشار على واحد واحد من الناس.ونحن قائلون
الآن في الأَشياءِ التي منها يكون الإِذن والمنع لواحد واحد من الناس،
ومبتدؤن أولا بالإِخبار عن الأَشياء التي من أجلها يشير المشيرون فيأذنون
فيها أو يمنعون من أضدادها.ويشبه إِن يكون لكل واحد من الناس انفعال ما
وتشوق بالطبع للخير الذي يتشوقه الكل لنفسه ويشير به على غيره من غير إِن
يعرف واحد منهم ما هو ذلك الخير فيختارونه ويأثرونه على غيره، أو إِذا سئل
عنه أجاب فيه بجواب منبئ عن طبيعته، بل إِنما عند كل واحد منهم وجوده
فقط.وإِذا سئل واحد واحد منهم عما يدل عليه اسمه، أجاب فيه بجواب غير
الجواب الذي يجيب فيه الآخر.وإِنما يؤثره الجميع لمكان هذا الانفعال
الموجود له بالطبع عند الجميع.وهذا الخير في الجملة هو صلاح الحال وأجزاءُ
صلاح الحال.ولذلك فقد ينبغي إِن نفضل أولاً ما هو صلاح الحال بقول عام، ثم
نفصل أجزاءه ونخبر عن أضدادها وعن الأَشياءِ التي يكون فيها الإِذن والمنع
وهي النافعة في صلاح الحال أو الأَنفع فيه، أو الضارة فيه أو الأَضر
فيه.فإِن بهذا يتم لنا القول في الأَشياءِ التي منها تلتئم الأَقاويل
المشورية المستعملة مع جميع الناس.
قال: والذين تكلموا في هذه الصناعة فلم يتكلموا من هذه الأَشياءِ إِلا
فيما يجري مجرى الأُمور الكلية، مثل أنهم قالوا ينبغي للخطيب إِن يعظم
الشيءَ الصغير إِذا أراد تفخيمه، ويصغر الشيءَ الكبير إِذا أراد تهوينه،
وينبغي له إِن لا يأْذن في الأَشياءِ التي تفسد صلاح الحال ولا في
الأَشياءِ التي تعوق عن صلاح الحال أو تتجاوز صلاح الحال إِلى ضده، ولم
يقولوا ما هي الأَشياءُ التي بها يعظم الشيءُ أو يصغر، ولا ما هي
الأَشياءُ التي توجب اختلال صلاح الحال أو تعوقه أو تتجاوزه إِلى ضده.
قال: فأما صلاح الحال هو حسن الفعل مع فضيلة وطولٍ من العمر
وحياة لذيذة مع السلامة والسعة في المال وحسن الحال عند الناس مع تحصيل
الأَشياء الحافظة لهذه الأَشياء والفاعلة لها.وقد يشهد إِن هذا هو رسم
صلاح الحال المشهور إِن جميع الناس يرون إِن صلاح الحال هو هذا أو شيء
قريب من هذا.وإِذا كان صلاح الحال هو هذا، فأجزاؤه هي كرم الحسب وكثرة
الإِخوان والأَولاد واليسار وحسن الفعل والشيخوخة الصالحة، وفضائل الجسد،
مثل الصحة والجمال والجلد والجزالة والبطش والمجد والجلالة والسعادة
والفضيلة، وأجزاؤها مثل العقل والشجاعة والعفاف والعدالة والبر. فإِنه
هكذا أحرى إِن يكون الإِنسان موفورا مكفيا، أعني إِذا كانت له الخيرات
الموجودة من خارج والخيرات الموجودة فيه النفسانية والجسدانية.والتي من
خارج هي الحسب والإِخوان والمال والكرامة.وقد يظن أنه يُعَد مع هذه نفوذ
الأَمر والنهي والاتفاقات الجميلة وهي المسماة عند الناس سعادة.فإِن بهذه
الأَشياءِ تكون حياة المرء في سيرته حياة من لا ينقصه شيء من خارج ولا
يشوب خيره شيء مضاد.وإِذا كان هذا هكذا، فيجب إِن ننظر في كل واحد من هذه
ما هو بحسب النظر المقصود هنا وهو النظر المشهور.فأما الحسب فهو إِن يكون
القوم اللذين هو منهم هم أول من نزل المدينة أو يكونوا قدماء النزول فيها،
ويكونوا مع هذا حكاما أو رؤساء ذوي ذكر جميل وكثرة عدد، وأن يكونوا مع هذا
أحرارا لم يجز عليهم سِباء، أو يكونوا ممن نال الأُمور الجميلة المغبوطة
عند الناس، وإِن لم يكونوا حكاما ولا رؤساء.فأما النظر في الحسب هل هو من
الرجال فقط أو من النساءِ، فالظاهر من ذلك والمتفق عليه عند الجميع أنه
يكون أتم إِذا كان من كليهما.وينبغي إِن يستعمل الخطيب من ذلك المشهور في
أمة أمة.ومن شروط الحسب إِن يكون الرؤساءُ والأَحرار من أولئك القوم
اللذين شهروا بالفضيلة واليسار وغير ذلك من المكرمات لم ينقطع وجودهم في
القوم الذين هو منهم إِلى وجوده هو، بل يوجد في ذلك الجنس أبداً أشياخ
بهذه الصفة يخلفهم غلمان في تلك الخصال.فإِنه إِن انقطع الشرف في ذلك
الجنس الذي هو منهم لم يكن حسيبا.وإِن لم ينقطع منهم فهو حسيب، وإِن انقطع
فيمن ولد منهم.
وأما حسن الحال بالأَولاد وكثرتهم فهو مما لا خفاء به.وحسنالحال بالأَولاد
المشترك للجميع هو كثرة الغلمان وصلاحهم في فضائل الجسد وفضائل النفس.أما
في فضائل الجسد فبأربع: إِحداها الجزالة وهي إِن تكون خلقهم خلقا طبيعية
يفوقون فيها كثيرا من الناس.والثانية الجمال، والثالثة الشدة، والرابعة
البطش.فبهذه الأَربع يكون الغلمان صالحين في فضائل أجسامهم.وأما فضائل
النفس فيكونون صالحين باثنتين: بالعفاف والشجاعة.وأما ما قد يكون به صلاح
حال بعض الناس فكثرة الأَولاد من الذكور والإِناث.وصلاح الحال بالإِناث
أيضا يكون بفضيلتين في الجسد والنفس.أما في الجسد فاثنتان: العبالة وهو
عظم الأَعضاء العظم الطبيعي وكثرة اللحم الطبيعي لا اللون، والجمال.وأما
في النفس فثلاث: العفاف وحب الأُلفة وحب الكد.فإِن بهذه الفضائل يكمل
المنزل.وهذه الفضائل التي قلنا سبيلها إِن توجد في النساء كلهن اللاتي من
نسب ذلك الرجل على العموم، وفي الرجال كلهم على العموم، وفي أولاده الذكور
خاصة إِذ كان الولد به ألصق.
وقد ينبغي للخطيب إِن ينظر هل الفضائل في الأُمة التي هو منها هي هذه
الفضائل عندهم، أعني في أولادهم، أم ليس هي هذه.فإِن كثيرا من الأمم يربون
أولادهم الذكور والإِناث بالزينة والسمن.وهؤلاءِ يقول فيهم أرسطو إِنه قد
فاتهم النصف من صلاح الحال بالأَبناءِ.
فأما أجزاءُ اليسار بكثرة الدنانير والأرضين والعقار والأَثاث والأَمتعة
والمواشي وجميع الأَشياءِ المختلفة في النوع والجنس، وكل ذلك إِذا كانت
هذه الأَشياءُ في حفظ ومع حرية، وأن يكون فيها متمتعا، أي ملتذا، لا حافظا
لها فقط أو منميا.
قال: ومن الأُمور النافعة في اليسار والفاعلة له الأَشجار المثمرة والغلات
من كل شيءٍ، واللذيذ من هذه هو ما يجنى بغير تعب ولا نفقة.وحد الحفظ
والإِحراز للمال هو إِن يكون في الموضع الذي لا يتعذر منه عليه، وأن يكون
بالحال التي يمكن إِن ينتفع بها، مثل إِن كانت أرضا ألا تكون سبخة، وإِن
كان فرساً ألا يكون جموحاً.
وحد الحرية في المال إِن يكون إِليه التصرف في المال بالإِعطاء
والبيع والشراءِ.وأما التنعم بالمال فهو استعماله على طريق التلذذ به،
وإِنما اشترط في الغناء هذا الشرط لأنه إِن يكون الغنى في استعمال المال
أحرى منه إِن يكون في اقتنائه.لأَن الاقتناء هو فاعل الغنى.وأما الاستعمال
فهو الغنى بعينه.
وأما حسن الفعل على الرأي والصواب فهو الذي يظنه الكل فاضلا، وهو الذي
يغتني الشيء الذي يتشوقه الأًكثر لا محالة أو الأَخبار من الناس وذوو
الكَيْس والفطنة.
قال: وأما الكرامة فإِنها في زماننا هذا للمعتني بحسن الفعل.و إِكرام
الناس اللذين لهم العناية الحسنة بهم هي مكافأة على طريق العدل والحق، إِذ
كانت هذه الأَفعال ليس تكافئها الدنانير والدراهم.وليس يكرم اللذين لهم
العناية الحسنة بالناس فقط، بل واللذين يستطيعون إِن تكون لهم العناية
الحسنة، أعني اللذين لهم قوة على ذلك وإِن لم يفعلوا ذلك في حال
الإِكرام.والعناية بالناس التي تستوجب الكرامة هي العناية بتخليصهم من
الشرور التي ليس التخلص منها بهين، أو إِفادتهم الخيرات التي ليس إِفادتها
بالسهل.وهذه الأفعال الجميلة هي التي تكون عن الغنى أو السلطان أو ما أشبه
ذلك مما يكون للإِنسان به القدرة على أمثال هذه الأفعال.وقد يكرم كثير من
الناس على خيرات يسيرة لكنها تكون كثيرة بالإِضافة إِلى ذلك الزمان وإِلى
تلك الحال.فكأن الكرامة على الأشياءِ اليسيرة هي بالعرض، أي من جهة ما عرض
لتلك الأشياءِ إِن تكون كثيرة بالإضافة إلى ذلك الوقت أو الحال.
وأما الأشياءُ التي تكون بها الكرامة فمنها مشتركة لجميع الأُمم ومنها
خاصة.فالجاصة مثل الذبائح والقرابين التي كانت قد جرت عادة اليونانيين إِن
يكرموا الأموات، ومنها عامة وهي المراتب في المجالس والمسارعة إلى أقواله
وترك مخالفته والهداية التي توجب المحبة والقرب.فإِن الهدية جمعت أمرين:
بذل المال والكرامة، ولذلك كانت مستحبة لجميع الناس، وكل إِنسان يجد فيها
ما يتشوقه.وذلك إِن الناس ثلاثة أصناف: إِما صنف يحب الكرامة، وإِما صنف
يحب المال، وإِما صنف جمع الأمرين.والهدية قد جمعت متشوق هذه الأصناف
الثلاثة.
قال: وأما فضيلة الجسد فالصحة وذلك إِن يكونوا عريين من الأَسقام ألبتة
وأن يستعملوا أبدانهم، لأَن من لا يستعمل صحته فليس تغبط نفسه بالصحة، أي
ليس هو حسن الحال بها وهو بعيد من جميع الأَفعال الإِنسانية أو من أكثرها.
قال: وأما الحسن فإِنه مختلف باختلاف أصناف الأَسنان.فحسن الغلمان وجمالهم
هو إِن تكون أبدانهم وخلقهم بهيئة يعسر بها قبولهم الآلام والانفعال أي لا
يكونون غير محتملين للأَذى وأن يكونوا بحيث يستلذ إِن ينظر إِليهم عند
الجري أو الغلبة.
قال: ولذلك ما يرى الناس الغلمان الذين هم مهيئون نحو الخمس المزاولات
واللعبات حسانا جدا.ونعني بالخمس المزاولات واللعبات الأَشياء التي كان
اليونانيون يروضون بها صبيانهم، وهي العدو والركوب والمثاقفة والصراع
والملاكزة.
قال: وإِنما كان الناس يرون فيمن كان مهيئا نحو هذه الأَفعال الخمسة أنه
جميل لأَنه مهيأ بها نحو الخفة والغلبة.وإِذا شب هؤلاءِ الغلمان كانوا
لذيذي المنظر عند العمل في الحرب، وذلك بحسب الهيئة التي كانوا معدين بها
نحو الحرب.وأما الشيوخ فجمالهم هو أستلذاذ أفعالهم في الأَعمال التي هي
جد، وهي التي من أجلها يراض الصبيان على هذه اللعبات الخمس، وهي الحروب،
وأن يكونوا مع ذلك يرون غير ذوي أحزان ولا غم، وذلك إِن الحزن والغم إِذا
ظهر بالشيخ ظن به إِن ذلك الطارئ الذي طرأ عليه مما يضر في شيخوخته، مثل
الفقر أو الهوان أو غير ذلك.
قال: وأما البطش فإِنه قوة يحرك المرءُ بها غيره كيف شاءَ.فإِنه إِذا جذب
غيره أو دفعه أو أشاله أو أخرجه أو ضغطه، وكان هذا الفعل منه بكل من يتصدى
له أو بأكثرهم، فهو ذو بطش.
قال: وأما فضيلة الضخامة فهو إِن يفوت كثيراً من الناس ويجاوزهم في الطول
والعرض والعمق، وتكون مع ضخامته حركاتُه غير متكلفة لجودة هذه
الفضيلة.وتكون ضخامته ليس سببها سمنا ولا أمراً مكتسبا.
قال: وأما الهيئة التي تسمى الجهادية فإِنها مركبة من الضخامة
والجلد والخفة.وذلك أنه إِذا اقترنت الخفة مع القوة أمكن إِن يبلغ بالسرعة
أمداً بعيدا؛ لأَنه إِن كان خفيفا دون جلد لم يبلغ بالسرعة أمدا
بعيدا.وذلك إِن الذي جمع الضخامة والقوة هو مصارع.والذي جمع الضخامة
والقوة والخفة هو مجاهد.وأما الذي جمع الصراع والخفة معا فيسمى عندهم باسم
مشتق من الحذق باستعمال القوة والخفة.وأما الذي جمع هذه الخصال كلها فهو
الذي يسمى عندهم ذا الخمس اللعب.
قال: وأما الشيخوخة الصالحة فإِنها دوام الكبر مع البراءة من الحزن، لأَنه
إِن عجلت وفاة الإِنسان قبل إِن يبلغ منتهى الشيخوخة لم يكن ذا شيخوخة
صالحة، وإِن كان بريئا من الأَحزان؛ ولا إِن أمهل إِلى منتهى الشيخوخة
وكان في كرب وحزن كان ذا شيخوخة صالحة.وإِنما يكون بريئا من الأَحزان إِذا
كان ذا حظ من الجد وفضائل البدن، أعني إِن يكون صحيحا ولم تعتره مصائب
تكدر شيخوخته.وذلك أنه إِذا كان ممارضا، أو كان الجد غير مساعد له بأن
يكون قد اعترته مصائب، فإِنه ليس بصالح الشيخوخة، وإِن كان معمرا، وكذلك
إِن كان ممارضا.وقد يشك كيف يكون طول العمر مع الأَمراض، لكن يشبه إِن
تكون قوة طول العمر غير قوة الصحة.فإِنا نرى قوما كثيرين تطول أعمارهم مع
أنهم مسقامون.وتصحيح هذا هو للعلم الطبيعي، وليس في تصحيحه في هذا العلم
منفعة.والخطيب إِنما يكتفي من ذلك بالشيءِ الظاهر.
قال: وأما كثرة الخلة وصلاح حال الإِنسان بالإِخوان فذلك أيضا غير خفي،
إِذا حُد ماهو الخليل والصاحب وهو إِن يكون كل واحد منهما يفعل الخير الذي
يظن أنه ينفع به الآخر، لا الخير الذي ينتفع به في نفسه فقط.وإِذا كانت
الخلة والصحبة هي هذه، فبيّن إِن المرءَ يكون صالح الحال بالإِخوان
الكثيرة.
قال: وأما صلاح الجد فهو إِن يكون الاتفاق لإِنسانٍ ما علة لوجود الخير له
وذلك إِما من الخيرات الموجودة في ذاته، وإِما من الخيرات الموجودة له من
خارج.وعلة الاتفاق قد تكون الصناعة، وقد تكون الطبيعة وهو الأَكثر.فمثال
ما يكون عن الاتفاقالطبيعي إِن يولد الإِنسان ذا قوة وهيئة يعسر بها قبوله
الأُمور الواردة عليه من خارج.فأما إِن يكون الإِنسان صحيحا، فقد يكون
سببه الاتفاق الطبيعي مثل إِن يولد صحيحا، وقد يكون الاتفاق الصناعي مثل
إِن يسقى سما فيبرأ به من مرض كان به.وأما الجمال والضخامة فعلتهما
الاتفاق الصناعي والطبيعي.وجملة الأَمر إِن الخيرات التي سببها الجد الذي
هو حسن الاتفاق هي الخيرات التي يكون المرءُ مغبوطا بها محسودا
عليها.ويكون الجد علة لخيرات ليست هي خيرات بالحقيقة وإِنما ترى خيرات
بالإِضافة والمقايسة إِلى الغير، كما قد يكون القبح في حق إِنسانٍ خيراً
ما إِذا رئى غيره أقبح منه.ومثل إِن يكون إِنسانان وقفا من الحرب في موضع
واحد فأصاب أحدهما السهم ولم يصب الثاني.فإِن الذي لم يصبه السهم يرى أنه
قد ناله بالإِضافة إِلى صاحبه خير كثير، وبخاصة إِن كان ذلك الذي لم يصبه
السهم من عادته إِن يشهد الحروب كثيرا، والآخر لم يشهد قط إِلا تلك الحرب.
وكذلك إِذا وجد الكنز واحد ممن طلبه، قد يرى أنه خير بالإِضافة إِلى من لم
يصبه، وإِن كان الكنز يسيرا.فمن هذا ونحوه وينظر الخطيب في سعادة الجد.
وأما تعريف الفضيلة فأولى المواضع بذكرها هو عند القول في الأَشياءِ التي
يمدح بها، لأَن الفضيلة خاصة بالمادح.ولذلك وجب إِن يكون المادح هو الذي
يعرف باستقصاء الفضيلة.والفضائل وإِن كان منها مستقبل وحاضر، فالمادح
إِنما ينظر فيها من جهة ما هي حاضرة، والمشير من جهة أنها مستقبلة، أي
نافعة.
فهذه هي الغايات التي من أجلها يشير المشير.وبيّن من هذه أضدادها التي من
أجْلها يمنع المشير وهي التي تؤلف منها أقاويل المنع، إِذ كان عددها هو
ذلك العدد بعينه، ووضعها من الأَقاويل المشورية هو ذلك الوضع بعينه.ومن
أجل إِن المشير إِنما غرضه المقدم في فكره هو إِن يشير بالشيءِ النافع
الذي تلزم عنه واحدة واحدة من هذه الغايات، وذلك إِن هذه الغايات هي أول
الفكرة وآخر العمل، والأَشياءُ النافعة هي آخر الفكرة وأول العمل، وأعني
بأول الفكر النتيجة، وبآخر الفكر المقدمات.
فقد يجب إِن يكون للخطيب أصول وقوانين يعرف بها الأَشياءَ
النافعة في الغايات، وهي العواقب إِذ كانت هي أول العمل.والنافعات وإِن لم
تكن خيراً مطلقا فهي خير لأَنها طريق إِلى الخير بإِطلاق.فالخير المطلق هو
الذي يختار من أجل نفسه، ويختار غيره من أجله، وهو الذي يتشوق إِليه الكل،
وأعني هاهنا بالكل ذوي الفهم الحسن من الناس والذكاءِ.وذلك قد يكون خيرا
في الحقيقة، وقد يكون خيرا في الظن، وذلك بحسب اعتقاد إِنسان إِنسان في
هذا الخير.ولذلك إِذا كان الشيءُ الذي يعتقد فيه الإِنسان هذا الاعتقاد
موجودا له فقد اكتفى به ونال حاجته ولم يبق له تشوق إِلى شيء
أصلا.والأَشياءُ النافعة في هذا الخير هي بالجملة أربعة أجناس: الأَشياءُ
الفاعلة، والأَشياءُ الحافظة له، وما يلزم الحافظة، وما يلزم الفاعلة.وذلك
إِن لازم الشيء يعد مع الشيء.وكذلك أيضا يعد لازم المفسد مع المفسد، ولازم
ضد الفاعل مع ضد الفاعل في الأَشياء التي ينهى عنها.ولزوم الغاية للفاعل
ربما كان معا مثل ما يلزم المدح اقتناء الأَشياء الممدوحة، وربما كان
متأخرا مثل العلم الذي يتبع التعلم بأخرة.
والأَشياءُ الفاعلة ثلاثة أصناف: إِما بالذات، وإِما بالعرض.والذي بالذات
اثنان، إِما قريب مثل فعل الغذاء الصحة، وأما بعيد مثل الطبيب.والذي
بالعرض مثل فعل التعب في الرياضة للصحة.وإِذا كان واجبا إِن تكون أصناف
الأَشياء الفاعلة للخير هي هذه الأَصناف الثلاثة، فباضطرار إِن تكون
الأُمور النافعة في الخير بعضها خير في ذاته مثل نفع الغذاء في الصحة
وبعضها شر في ذاته وخير ما بحسب نفعه في الخير مثل شرب الدواء
للصحة.والشرور التي تنفع في الخير هي نافعة على وجهين: أحدهما إِن يستفاد
بها خير هو أعظم من الشر اللاحق من استعمالها مثل استفادة الصحة عن شرب
الدواءِ، ومثل المشقة اليسيرة في استفادة المال الكثير.ومنها ما تنال به
السلامة من شر هو أعظم من الشر الذي ينال منها، مثل ما ينال رُكَّابُ
البحر من السلامة إِذا طرحوا أمتعتهم.فإِن طرح أمتعتهم شر، لكن تستفاد منه
السلامة من شر هو أعظم وهو العطب.والخيرات التي تستفاد من الخيرات يسميها
أرسطو فوائد بإِطلاق، وأما تلك فيسميها انتقالا.ويعني بذلك أنها انتقال من
شر إِلى ما هو أخف شرا منه أو انتقال من شر إِلى ما هو خير.
قال: والفضائل وإِن كانت غايات فهي أيضا خيرات في أنفسها ونافعة في
الخير.فإِن المقتنين لها هم بها حسنو الأَحوال.وهي مع هذا فاعلة للخير
ومستعملة فيه.
قال: وقد ينبغي إِن نخبر عن كل واحد من هذه وكيف هي خير في نفسها وكيف هي
فاعلة للخير ونفصل الأَمر في ذلك.واللذات أيضا هي خير بنفسها لأَن جميع
الحيوان يشتاق إِليها.والأُمور اللذيذة إِنما تكون خيراً إِذا كان بها
الملتذ حسن الحال.وقد يستبين من التصفح أنها خير وأنها أيضا قد تكون نافعة
في الخير.وأجزاءُ صلاح الحال بالجملة منها ما هي غايات فقط، ومنها ما قد
تعد غايات وهي نافعة أيضا في الغايات؛ وذلك إِن لبعضها ترتيبا عند بعض،
أعني إِن بعضها علة لوجود بعض ومتقدم عليه.ومثال ذلك إِن الشجاعة والحكمة
والعفاف وكبر النفس والنبل وما أشبهها من فضائل النفس قد تختار أشياء
كثيرة من أجزاءِ صلاح الحال من أجلها.وكذلك الصحة والجمال من فضائل الجسد
قد تختار أشياء من أجلها هي من صلاح الحال وهي فاعلاتها.وكذلك تختار
فاعلات أشياء أخر من صلاح الحال مثل فاعلات اللذة وفاعلات السيرة
الحسنة.ولذلك ما يظن باليسار أنه خير، إِذ كان سببا لهذين الأمرين
الشريفين: أحدهما اللذة، والآخر حسن السيرة.وصلاح الحال بكثرة الإِخوان قد
يوجد فاعلا لأَشياء كثيرة من الخيرات.وذلك إِذا كانت الصداقة التي بينهما
من أجل المحبة نفسها، لا إِن تكون المحبة بينهما من أجل شيءٍ آخر.فإِن
الإِخوان اللذين بهذه الصفة هم يفعلون الكرامة والتمجيد بغير ذلك مما يجري
مجراهما من الخيرات.وذلك يكون منهم بالقول والفعل.فإِن الأَقوال والأَفعال
التي تفعل بها الكرامة والتمجيد وغير ذلك مما يجري مجراهما هي خير ونافع.
قال: ومن النافعات بذاتها الملكات الطبيعية التي يكون الإِنسان
بها مستعدا لأَشياء حسنة مثل الذكاء والحفظ والتعلم وخفة الحركات، وكذلك
الكمالات مثل العلوم والصنائع، وكذلك السير المحمودة.وهذه كلها مع أنه
نافعة في غيرها هي خير في نفسها وإِن لم يتصل بها خير آخر، فهي خيرات
منفردة بأنفسها مختارة لذاتها.والبر أيضا خير نافع.
قال: فهذه هي الخيرات التي يعترف بها ويجتمع على أنها خيرات ونافعات.ومتى
بيَّن في شيء منها أنه خير فذلك بيان لا على طريق المراء والمغالطة
المستعملة في هذه الصناعة.وأما إِذا بيّن في شيء من أضداد هذه أنها خير،
وفيها أنها شر فذلك يكون في هذه الصناعة على طريق المراء، أعني بيانا
سوفسطائيا.وذلك إِن الشر إِنما ينفع بالعرض، مثل إِن يبين خطيب لأَهل
مدينةٍ ما إِن الجبن لهم خير لأَنهم إِن شجعوا، خرجوا عن المدينة، فنال
منهم العدو.ولكن الجبن ليس لهم خيرا على الإِطلاق وإِنما كان خيرا
بالإِضافة إِلى أهل المدينة الذين عرض لهم ذلك.وأما النافع في الأَكثر
وبالذات للإِنسان فهو الخير، كما إِن الشر المضاد للخير هو نافع
للأَعداءِ.وذلك إِن الجبن، لما كان شرا لأَهل المدينة بالذات، كان نافعا
للأَعداءِ.والشجاعة لما كانت بالذات خيرا لهم كانت ضارة بالأَعداءِ.إِلا
أنه قد يلحق ما هو شر ما للإِنسان إِن يكون ضارا لعدوه، وما هو خير ما له
إِن يكون نافعا لعدوه، مثل الجبن لأَهل المدينة اللذين إِذا خرجوا عن
المدينة لم يكن لهم قوة يقاومون بها عدوهم.فينبغي للخطيب إِن يتحرى في كل
وقت النافع من هذه الأَشياء.وهذه القضية أيضا ليست كلية، أعني القائلة إِن
كل ما يضر العدو ويكرهه نافع، وكل ما ينفع العدو ويسره ضار.
فإِن كثيرا ما يكون الأَمر الواحد ضارا للإِنسان وعدوه ونافعا للإِنسان
وعدوه.فمثال ما هو نافع لكليهما ويسر به كل واحد منهما مفارقة العدو عدوه
إِذا كانت بعد مقاتلة شديدة بينهما ومقاومة أشفى كل واحد منهما على العطب
منها من غير إِن يظفر أحدهما بصاحبه.فإِنهما إِذا افترقا في أثر هذه الحال
سُرَّ كل وَاحد منهما بالافتراق.ولذلك قد يكون النافع نافعا للأعداء
أيضا.وأما ماهو ضار لكليهما فكثيرا ما يوجب صداقة العدو، وذلك إِذا كانا
متساويين في نزول الشر الوارد بهما من غير إِن يفضل أحدهما في ذلك
صاحبه.وكثير من الأُمم المختلفة كان اتفاقهم بهذا السبب.ولذلك قيل إِن
الشر قد يجمع الناس.فهذا أيضا أحد ما يكون به الشر نافعا، أعني إِن يكون
الضر النازل بالإِنسان نازلا بعدوه، فإِن ذلك يوجب صداقة العدو.وحينئذ
يهوى العدو الوارد ضد ما يهواه كل واحد من المتعاديين الذين ورد عليهما
العدو من خارج.وذلك إِن كل واحد من المتعاديين يهوى صداقة صاحبه لمكان
تعاونهما على العدو الوارد عليهما من خارج.والعدو الوارد يهوى بقاء
عداوتهما على حالها أو تأكدها.وأرسطو يقول: ولذلك كثيرا ما تنفق النفقات
العظيمة وتفعل الأَفعال الكثيرة في مثل هذا الخير الذي يدفع به الشر
العظيم.وإِنما تطيب النفس بالنفقات في مثل هذه الأَشياءِ لظهور ما يلزم
عنها من الغاية المطلوبة وقربها حتى كأنها إِذا وجدت هذه الأَشياءُ وجدت
الغاية.وقد يكون الشر المفرط النازل بالعدو أيضا سببا للاعتراف بالخير
اليسير الذي ناله من عدوه، ولولاه لم يعترف به العدو.مثل ما حكي أرسطو أنه
عرض لبعض الملوك الذين كانوا أعداء لليونانيين أنه اشتدت محاربتهم له
وحصرهم إِياه سنين كثيرة وقتلوا في ذلك الحصار ابنه فسألهم إِن يعطوه جثته
ليحرقها على عادتهم في موتاهم ففعلوا ذلك فشكرهم على ذلك وأظهر شكرهم عند
جميع قومه وأهل مدينته.فلولا ما نزل به من الشر العظيم، لما شكرهم على هذا
الشيءِ اليسيرالذي سمحوا له به، كما قال ذلك أُوميروش الشاعر.
قال: ومن الاصطناعات النافعة والأَفعال التي يعظم قدرها عند
المصطَنَع إِليهم فيصير به المصطنع إِلى خير عظيم من المصطنع إِليهم إِن
يختار الإِنسان إِنسانا عظيم القدر من جنس ما من الناس له أيضا عدو عظيم
القدر في جنس آخر من الناس فيفعل بعدو ذلك الإِنسان الشر وبأصدقائه الخير،
مثل ما عرض لأُوميروش مع اليونانيين وأعدائهم، فإِنه قصد إِلى عظيم من
عظماء اليونانيين في القديم فخصه بالمدح وأصدقاءه من اليونانيين، وخص عدوا
له عظيما بالهجو هو وقومه المعادين لليونانيين في حروب وقعت بينهما، فكان
رب النعمة العظيمة بذلك عند اليونانيين وعظموه كل التعظيم حتى اعتقدوا فيه
أنه كان رجلا إِلاهيا وأنه كان المعلم الأَول لجميع اليونانيين.وبالجملة:
ففعْل الشر بالأَعداءِ والخير بالأَصدقاءِ من الأُمور النافعة، ومن شرط
هذا الفعل الذي يعظم موقعه إِن موقعه إِن يكون ما فعل منه يرى أنه لم يمكن
الفاعل ولا تيسر له غيره، وسواء كان الفعل كثيرا في نفسه أو يسيرا، وأن
يظن إِن فعله له لم يكن لمكان خوف ولا شيء يرجوه، بل لأَن شوقه وهواه قاده
إِلى ذلك.فإِن بهذا يكون الفعل مداوما عليه من الفاعل وهو السهل عليه.لأَن
الأَفعال التي تكون من أجل خوف إِنما تكون غير شاقة زمانا يسيرا.وإِذا طال
بها الزمان كانت شاقة فانقطعت.وإِذا انقطعت كان من ذلك عداوة من المصطنع
إِليه للمصطنع.فلذلك يشترط في هذا الفعل إِن يكون سهلا على الفاعل.فهذه هي
شروط الابتداءِ بالصنائع التي يعظم موقعها ويوجد نفعها.
وأما المكافأة التي لا يعظم موقعها فهي المكافأة التي لا تكون بحسب ما ما
يهوى المكافئ بالطبع من أكثر الناس، وهو إِن تكون ناقصة عن الصنيعة التي
أسديت إِليه: إِما في الكمية، وإِما في المنفعة، وإِما لأَنها قد فضلت عند
المكافئ وليس يحتاج إِليها.وهي المكافأة التي يغالط فيها.وإِنما كان
المكافئ بالطبع الذي يشتهي إِن تكون مكافأته بأحد هذه الثلاثة الأَحوال،
لأَن المكافئ كأنه مقصور على الإِعطاءِ، فهو إِنما يشتهي: إِما ألا يلحقه
نقص من الخير الذي وصل إِليه، وإِما إِن يكون النقص أقل من الخير الذي وصل
إِليه.فإِذا لم تكن المكافأة بهذه الصفة، بل كانت مقارنة للصنيعة: إِما في
الجنس مثل أَن تكون المكافأة على الدنانير بدراهم، وإِما في القوة مثل أن
تكون المكافأة على المال بكرامة يقتنى بها مثل ذلك المال، فهي المكافأة
العادلة لكنها سوقية. فإِذا لم تكن المكافأة لا سوقية ولا فيها غبن، بل
كان المكافئ يعتقد فيه أنه ليس اختياره في المكافأة لما هو أنقص أكثر من
اختياره لما هو أزيد، وسواء وقعت مكافئته بما هو أنقص أو بما هو مساوٍ أو
بما هو شبيه، فهي المكافأة الجميلة. لأَن مكافأته بالأَنقص لم تكن منه
باختيار لذلك، بل لأَنه لم يتسير له غير ذلك. فإِذا اتفق أن يكون مع هذا
ذلك الفضل مما يسر به الأَصدقاء، أعني أصدقاء المكافئ بالفعل، ويسوء
أعداءه، ويكون مع هذا متعجبا منه عند الجمهور، وذلك بالإِضافة إِلى من صدر
عنه، كان عظيما موقعه من المصطنع إِليه، وبخاصة إِذا كانت الصنيعة مما
توافق شهوة المصطنع إِليه، مثل أن يكافئ أو يبدأ محب الكرامة بالكرامة
ومحب المال بالمال، ومحب الغلبة بالغلبة.
فإِن هذه الصنيعة ليست هي لذيذة فقط عند الذي تصطنع إِليه أو يكافئ بها،
بل هي عنده فاضلة. وكذلك الأَمر في سائر أصناف الخيرات. وإِنما تكون أفعال
الصنائع والمكافأة على المبتدئ و المكافئ أفعالا سهلة يمكن أن يداوموا
عليها متى كانوا باستعدادهم الطبيعي مهيئين لتلك الأَفعال، وكانت قد حصلت
لهم الملكة التي بها تصدر عنهم تلك الأَفعال. ومن الصنائع اليسيرة التي
يظن بها أنها ليس تنقص المصطنع شيئا بالتأديب والموعظة.
قال: فمن هذه الوجوه يأخذ الخطيب المقدمات التي منها يقنع أن الشيءَ نافع
أو غير نافع. ومن أجل أن الخطيب قد يعترف أحيانا بأن الأَمر نافع، ولكن
يدعى أن هاهنا شيئا هو أنفع، فقد يحتاج أن يكون عنده مواضع يقدر أن يبين
بها أن الأَمر أنفع وأفضل.
فمنها أن ما كان نافعا في كل الأَشياءِ، فهو أنفع مما هو نافع في
بعض الأَشياءِ. والذي هو أدوم نفعا، هو أنفع من الذي أقصر نفعا. والذي هو
أكبر، هو أنفع من الأَصغر. والذي هو أكثر، هو أنفع من الأَقل. والذي جمع
من صفات الخير أكثر، أو جمع صفاته كلها، فهو أنفع. وصفات الخير التام هو
أن يكون الشيء مختارا من أجل نفسه، لا من أجل غيره، وأن يكون متشوقا عند
الكل، وأن يكون ذوو الفضل واللب يختارونه. والذي جمع هذه الصفات كلها أو
أكثرها فهو الخير والنافع الذي في الغاية وهو الغاية لسائر الأَشياء التي
توصف بالخير. والأَشياءُ المتصفة بالخير المتعلقة بهذا الخير الذي جمع هذه
الصفات إِنما يقال فيها إِنها أنفع إِذا وجد في واحد منها صفة واحدة من
هذه الصفات أو أكثر من صفة واحدة. وكل ما كان من هذه الأَشياء توجد فيه
صفات أكثر من صفات الخير فهو أنفع، ما لم تكن الصفة الواحدة أنفع من
اثنتين أو من ثلاث. وأيضا فما كان العظيم فيه أفضل من العظيم في جنس آخر،
فالجنس الذي فيه العظيم الأَفضل هو أفضل من الجنس الآخر. وما كان الجنس
منه أفضل من الجنس الأَفضل، فالعظيم من الجنس الأَفضل أفضل من العظيم من
الجنس الآخر. وهذا عكس الأَول. ومثال ذلك أنه إِن كان الذكران أفضل من
الإِناث، فالرجل أفضل من المرأة، وإِن كان الرجل أفضل من المرأة، فالذكران
أفضل من الإِناث. وإِنما كان ذلك كذلك لأَن نسبة العظيم إِلى جنسه هي
كنسبة العظيم الآخر إِلى جنسه. فتكون نسبة الجنس إِلى الجنس هي نسبة
العظيم إِلى العظيم.
ثم إِذا كان الشيءُ لازما لشيء ما، والآخر غير لازم له،فإِن الذي يلزم عنه
الشيء آثر من الذي لا يلزم عنه الشيء. مثال ذلك السلطان والثروة. فإِن
الثروة تلزم السلطان، وليس يلزم السلطان الثروة؛ فلذلك السلطان أفضل من
الثروة. وكذلك الحال في المضار. فإِن الفقر يلزم عنه البخل، وليس يلزم عن
البخل الفقر؛ فالفقر أكثر شرا من البخل.
واللازم يوجد على ثلاثة أقسام: إِما أن يوجد معا، أعني اللازم والملزوم،
مثل وجود الأبيض والبياض معا، ومثل لزوم الإِنسان والحيوان. وإِما أن يوجد
اللازم تابعا بأخرة مثل لزوم العلم عن التعلم. وإِما أن يكون تلازمهما في
القوة، أي يكون أحدهما يفعل فعل الآخر ولا ينعكس، أعني ألا يفعل الآخر فعل
الأَول، مثال ذلك الفقر والبخل. فإِن الفقر يلزم عنه أن يفعل الإِنسان فعل
البخل، وليس يلزم عن البخل فعل الفقر. فإِن الفقر يعوق عن أشياءِ أكثر من
عدم استعمال المال الذي هو البخل.
وأيضا الذي يفعل الخير الأَنفع هو أنفع من النافع. مثال ذلك الجِلْد
والجمال. فإِن كليهما نافع وخير. والجلد يفعل به خير أعظم مما يفعل
بالجمال، فهو أعظم نفعا. كذلك الصحة أيضا أعظم نفعا من اللذة، لأَن الصحة
يفعل بها خيرات أكثر مما يفعل باللذات. وأيضا فإِن الذي يختار مفردا أفضل
نفعا من الذي لا يختار إِلا مع ذلك المختار مفردا. ومثال ذلك أن الجمال لا
يختار إِلا مع الصحة، والصحة تختار دون الجمال؛ فالصحة أفضل نفعا من
الجمال. وأيضا إِذا كان شيئان أحدهما كمال، والآخر طريق إِلى الكمال فالذي
هو كمال أفضل، مثل الصحة واللذة. فإِن الصحة كمال، واللذة كون، والكون
طريق إِلى الكمال. وإِذا كان شيئان أحدهما يختار لذاته، والآخر يختار من
أجل غيره، فالذي يختار من من أجل نفسه أفضل من الذي يختار من أجل غيره،
مثال ذلك الحكمة واليسار. فإِن الحكمة تختار لذاتها، واليسار يختار لغيره.
وأيضا فإِن الذي يجعل المرء إِذا اقتناه أقل حاجة إِلى أصدقائه أو إِلى
الإِنسان فهو أفضل من الذي يجعله أكثر حاجة. فإِن من هو أكثر كفاية
واستغناء عن الناس هو الذي يحتاج إِلى أشياء قليلة العدد سهل وجودها.
وأيضا إِذا كان شيئان أحدهما يحوج اقتناؤه إِلى الثاني، والثاني لا يحوج
اقتناؤه إِلى الآخر، فإِن الذي لا يحوج اقتناؤه إِلى الآخر هو آثر، مثال
ذلك اليسار والبنون. فإِن البنين يحوجون إِلى اقتناءِ المال، واليسار ليس
يحوج إِلى اقتناءِ البنين؛ فاليسار أفضل نفعا.
قال: ويستبين أن الشيءَ الذي هو مبدأ ليس يلزم أن يكون أعظم من
الشيءِ الذي هو له مبدأ، وذلك أن الإِرادة مبدأ الخير،و وفعل الخير أعظم
من إِرادة الخير. وكذلك التعلم والعلم. وإِن كان ليس يمكن أن يكون الشيءُ
النافع دون مبدأ. وإِذا كان شيئان مبدأين لشيئين، وأحد المبدأين أعظم من
الثاني، فإِن الذي يكون عن المبدأ الأَعظم أعظم. وعكس هذا أيضا: وهو إِذا
كان شيئان مبدأين لشيئين على أنهما فاعل، وأحدهما أعظم من الثاني، فإِن
الذي هو مبدأ للأَعظم أعظم. وكذلك إِذا كان مبدأين على أنهما غاية، وإِذا
قيس المبدأ الفاعل إِلى الغاية، أمكن أن يتوهم أن الفاعل أعظم من الغاية
وذلك أن الفاعل هو الذي يفعل الغاية، ولولا هو لم توجد الغاية. وأمكن أن
يتوهم أيضا أن الغاية أعظم من المبدأ، وذلك أنه لولا الغاية لكان الفاعل
فضلا. فمثال ما تجعل الغاية فيه أعظم من الفاعل قول من يقول في الذم: إِن
فلانا أولى بأن ينسب إِلى الجور في فعله كذا من فلان الذي أشار عليه بذلك،
لأَنه لو لم يرد، لم يكن منه ذلك الفعل. إِذ لو لم يفعل هو ذلك الفعل، لم
يقع ذلك الضرر. ومثال ما يجعل الفاعل فيه أعظم من الغاية قول القائل: فلان
أحق بالشكر على هذا الفعل من فلان، لأَن فلانا هو الذي أشار عليه بذلك
الفعل، ولولا إِشارته لم يكن ليفعل ذلك الفعل المحمود. وفي كلا الموضعين
ما قبل الغاية إِنما يفعل لمكان الغاية.
وأيضا فإِن الذي وجوده أقل فهو أفضل، مثل الذهب والحديد. غير أنه إِن كان
الذهب أقل وجودا من الحديد فليس هو أنفع. وأيضا مقابل هذا: وهو أن ما كثر
وجوده فهو أفضل مما قل وجوده لكثرة منافعه. ومن هنا يقال: إِن الماءَ خير،
لكثرة وجوده وعموم منافعه. وأيضا فإِن ما هو أعسر وجودا فهو أفضل، لأَن ما
عسر وجوده قل وجوده، وما قل وجوده، فهو غريب ومتنافس فيه. ومقابل هذا: وهو
أن ما سهل وجوده فهو أفضل، لأضنه يوجد في كل حين يتشوق إِليه. وأيضا الشيء
الذي ضده أعظم، فهو أفضل. وأيضا الذي عدمه أشد ضررا فهو أنفع. وليس ينبغي
أن يفهم هاهنا من الأَعظم والأَقل عظم المقايسة في الخير فقط، بل وفي
الشر، وفيما هو لا خير ولا شر. وأيضا فإِن الغايات والأَشياءَ التي من
أجلها تفعل الأَفعال، إِذا كانت الغايات بعضها أزيد خيراً من بعض، أو أزيد
شرا من بعض، فإِن الأُمور المتقدمة لتلك الغايات الأَزيد هي أزيد. وأيضا
فإِن ما كان من الملكات والفضائل، وبالجملة: الأَشياءُ الفاعلة أعظم، فإِن
أفعالها الصادرة عنها تكون أعظم، لأَن نسبة الأَفعال إِلى مبادئها هي نسبة
المبادئ بعضها إِلى بعض. فإِنه إِذا كان البضر آثر من الشم، فإِن الإِبصار
آثر من الشم. وهكذا يوجد الأَمر في جميع الأَفعال مع أسبابها الفاعلة ليس
فس الذاتية فقط، بل وفيما يعرض عن الشيء بالاتفاق. فإِن العظيم يكون
الاتفاق الذي يعرض له عظيما. وفي الأَعراض الموجودة في الشيءِ، أعني أن
الشيءَ الأَعظم، العرض الموجود فيه أعظم. وأيضا أن يحب الإِنسان صاحب
المال أفضل من أن يحب المال، لأَن حب الإِنسان أفضل من حب المال. وأيضا
فإِن الفضائل أفضل من ذوي الفضائل. والأَشياءُ التي شهوتها فاضلة أفضل من
التي شهوتها غير فاضلة. مثال ذلك أن شهوة العلوم فاضلة وشهوة الأَكل
والشرب غير فاضلة، فالعلوم أفضل من الأَكل والشرب. وأيضا عكس هذا: وهو أن
ما هو أفضل، فشهوته أفضل، مثل أن الحكمة أفضل من النكاح، فشهوتها أفضل من
شهوة النكاح. وأيضا فإِن العلوم التي هي أحسن وأفضل، فأفعالها خير وأفضل.
مثال ذلك أنه لما كانت العلوم العلمية أفضل من العملية، كان فعلها الذي هو
الصدق أفضل من التي فعلها العمل. وعكس هذا: وهو أن التي فعلها أفضل من
العلوم، فهي أفضل؛ وذلك أن الوقوف على الحق لما كان أفضل من العمل، كانت
الصنائع العلمية أفضل من العملية. وإِنما كان هذان الموضوعان متلازمين،
لأَن نسبة الصناعة إِلى الصناعة هي نسبة فعلها إِلى فعلها.
قال: والذي يحكم به الكل من الجمهور أو الأَكثر أو ذوو الأَلباب
والأَخيار الصالحون أنه خير وأفضل، فهو أفضل بإِطلاق وفي نفسه، إِذا كان
حكمهم في الأَشياءِ بحسب فطرهم وكانوا ذوي لب، لا بحسب ما استفادوه من
الآراءِ من خارج. فإِن ذوي الأَلباب من الناس قد يقولون بفطرهم في الفضائل
والخيرات ما هي، وكم هي، وعند أي شيء هي، وإِن كان ما يقفون عليه بفطرهم
دون ما يوقف عليه من ذلك في العلوم. وما قيل في حد الخير من أنه الذي
يتشوقه الكل، إِنما يراد بذلك الخير الذي يتشوقه الكل بحسب فطرهم الطبيعة،
أعني اللبيبة. فإِن ما تتشوقه الفطر اللبيبة، بما هي فطر لبيبة، هو خير
مطلق، أو خير أفضل من خير، مثل علمهم أن الشجاعة والأَدب والجلَد خيرات
وتشوقهم إِياها. وأما الذي هو خير بالإِضافة إِلى إِنسان ما، مثل من يرى
من الناس الفاضلين أنه أن يجار عليه أفضل من أن يجور هو، فإِن هذا الخير
لا يدركه الناس بحسب طباعهم، وإِنما يرى هذا الرأي الذي هو من الناس في
غاية العدل والفضل.
وأيضا ما كان من الخيرات معه لذة، فهو آثر مما ليس معه لذة. وما كان من
الخيرات أكثر لذة، فهو آثر. وإِنما كان ذلك كذلك لأَن الكل من الجمهور
يبتدرون إِلى اللذة ويطلبونها. وطلبهم اللذة هو من أجل اللذة نفسها، لا من
أجل شيءٍ آخر غيرها. وما كان بهذه الصفة، أعني متشوقا للكل، فقد قيل أنه
الخير والغاية. فاللذة إِذَنْ خير. والأَزيد لذة هي الملذات التي هي أبرأ
من الأَذى والحزن وأدوم بقاء. واللذة الجميلة ألذ من اللذة القبيحة، لأَن
الجميل مما قد يختار بذاته وإِن لم يكن لذيذا، وهو من الأَشياءِ التي
يختار المرءُ أن يكون علة لكونه إِما لنفسه وإِما لصديقه. وبالجملة فكل ما
كان من الأَشياءِ الملذة أفضل فهو ألذ مما هو أخس. وكل ما هو منها أطول
مدة، فهو ألذ من التي هي منها أقصر مدة. وكل ما كان من الخيرات أثبت فينا،
فهو ألذ مما هو أقل ثباتا. وذلك أن الصحة لما كانت أرسخ فينا من الجمال،
كان وجود الصحة لنا ألذ من وجود الجمال. والأَشياءُ اللذيذة أو الأَكثر
لذة إِنما السبب في وجودها لنا بهذه الصفة أحد أمرين: إِما طول اعتياد
الشيء حتى يصير لنا الإِلتذاذ به من قبل العادة كالحال في اللذة الحاصلة
عن العلم، وإِما من قبل أنها لذيذة جداً عندنا بالطبع والهوى. فالأَشياءُ
إِذن إِنما تصير أكثر لذة إِما من قبل طول الزمان، وإِما من قبل الهوى
والموافقة التي بالطبع. وجميع الأَشياء التي تلائم هوانا ملاءمة أكثر،
فإِن منفعتها لنا إِنما تكون في رسوخها وثبوتها. وقد تؤخذ مقدمات الأنَفع
والأَفضل من مواضع النظائر والتصاريف، وذلك أنه إِن كانت الشجاعة آثر من
العفاف، فالرجل الشجاع آثر من الرجل العفيف.
قال: وما اختاره أيضا كثير من الناس آثر مما يختاره القليل من
الناس. فإِن الخير كما قيل هو الذي يشتاق إِليه الكل. وما اختاره أيضا
الحكام الأَول، أعني اللذين لا يأْخذون الأَحكام من غيرهم، وهم الشرَّاع،
أفضل مما لم يختاروه. وما اختاره أيضا الذين يتلقون الأَحكام من هؤلاءِ
أفضل مما ليس يختاروه هؤلاءِ. واللذين يتلقون الأَحكام من الحكام الأَول،
وهم الذين تؤخذ عنهم أصول الأَحكام، صنفان: إِما سامع فقط مبلغ، وإِما
سامع عالم،أي قادر على أن يستنبط من تلك الأُصول أحكام ما لم يصرح به
الحكام الأُول. وهؤلاءِ صنفان: إِما مسلطون من قبل الحكام الأُول وهم
القضاة وما أشبههم، وإِما غير مسلطين وهم الفقهاءُ. ومن هذه الأَشياءِ ما
لجميع أصناف المتلقين من الحكام الأُول أن يقولوا فيها وهو ما سمعوه أو ما
شاهدوه من الحاكم الأَول، ومنها ما يختص بذوي العلم منهم وهو القول في
الأَشياءِ التي تستنبط عن الأَحكام الأُول التي صرح بها الحاكم الأَول.
وليس للسامعين دون علم أن يقولوا في هذه الأَشياءِ. وأما الذي يخص الحكام
الأُول القول فيه فهي الأُصول التي تتنزل منزلة المبادئ لسائر ما يحكم به
السامعون ذوو العلم، أعني المسلطين والفقهاء وهي التي يسميها أرسطو
الأُمور العظمى. والفضلاءُ الأَبرار الذين جرت العادة أن يأخذ عنهم الجميع
أو الأَكثر فحكمهم أفضل. فإِن عدم الأَخذ قد يخيل هوانا ونقصا في
المرءِالفاضل البر وقلة قبول لقوله. وقد يخيل الأَمر بعكس هذا، وذلك أنه
ربما كان هؤلاءِ الأَبرار الفاضلون مقبولي القول مع أنه لم يأخذ أحد من
الجمهور عنهم أصلا شيئا، أو إِنما أخذ عنهم قليل، وذلك أن أقاويل هؤلاءِ
قد يظن بها أنها مقبولة بجهة أخرى، وذلك أنه قد يكون المرضىّ عند الجمهور
من ليس مرضيا في نفسه. والأَقل من الجمهور هم ذوو التمييز. وأيضا فإِن
الفاضلين الذين كتموا فضائلهم عن الجمهور هم ممدوحون أكثر وهم أقل وجودا
وأعز، لأَنهم إِنما كتموا فضائلهم عن الجمهور لما خافوا أن يلحقهم من
الكرامات والرياسات التي يخاف إِذا لحقت المرء أن تكون سببا لأَن تكون هذه
الأَشياءُ اللاحقة للفضائل هي المقصودة عنده بالفضائل. فمن هاهنا صارت
أقوال هذا الصنف مقبولة، كما صارت أقوال الصنف الأَول المضاد لهذا مقبولة،
وهم الذين أخذ عنهم الجمهور.
قال: ومن الصنف المقبول القول من الناس جدا جدا الصنف الذين كراماتهم
أعظم، لأَن الكرامة لما كانت مكافأة الفضيلة كان المرءُ كلما عظمت كرامته
ظن به أنه قد عظمت فضيلته.
والصنف من الناس الذين نالتهم المضرة العظيمة والشقاءُ الكثير لمكان
الفضائل هم أيضا مقبولو الأَقوال جدا جدا بمنزلة سقراط وغيره. والصنف من
الناس الذين يَرى فيه هذان الصنفان من الناس - أعني الذين كرامتهم أعظم
والذين نالهم الضرر الكبير من قبل الفضائل - أنهم فاضلون ويعترفون لهم
بالفضل، هم أيضا أفضل وأعظم. فهؤلاءِ هم أصناف الناس الذين إِذا اختاروا
شيئا، واختار غيرهم سواه، كان ما يختاره هؤلاءِ أفضل و آثر.
قال: وقسمة الشيءِ إِلى جزئياته تخيل في الشيءِ أنه أعظم. ولذلك لما أراد
أوميروش الشاعر أن يعظم الشر الذي لحق المدينة أخذ بدله جزئياته، فذكر قتل
الأَولاد والنوح عليهم وحرق المدينة بالنار وغير ذلك من أصناف الشرور
اللاحقة لها.
قال: وكذلك التركيب قد يخيل في الشيءِ أنه أعظم، وهو عكس هذا، أعني أن
يؤخذ بدل الجزئيات الكلي الذي يعمها. والسبب في الإِقناع في هذين الصنفين
هو التغيير والإِبدال.
قال: ولما كانت الأَشياءُ الأَعسر وجودا في نفسها والأَقل وجودا
يظن بها أنها أفضل، كانت الأَشياءُ الكثيرة الوجود في نفسها والسهلة
الوجود قد ترى عظيمة، إِذا وجدت في المواضع التي يقل فيها وجودها، أو في
الأَزمنة التي يقل وجودها فيها أيضا، أو في الأَسنان من الناس التي يقل
وجودها فيها، مثل وجود الإِنسان خطيبا في سن الصبا، أو في المدد التي ليس
من شأنها أن يوجد فيها، مثل مَنْ يفعل ما شأنه أن يفعل في زمان طويل في
زمان قصير، أو تكون صادرة عن القوى التي يقل صدورها عنها، مثل أن يفعل
الضعيف فعل القوى والمريض فعل الصحيح. وكل هذه وأشباهها مما يصيّر الأَمر
الذي ليس بعظيم عظيما ومستغربا. وأيضا فإِن الجزء العظيم من الشيءِ هو من
الأَشياءِ التي هي أعظم مثل القلب من الحيوان والدماغ، أو الربيع من السنة
والشباب من المدينة. وأيضا فإِن النافع فيما الحاجة إِليه أشد هو أعظم
نفعا والضار فيه أكثر ضررا، مثل الصحة في الشيخوخة والمرض فيها، فإِن
الصحة فيها آثر من الصحة في الصبا والمرض فيها أضر. و أيضا ما كان من
الأَمرين أقرب إِلى الغاية فهو أفضل. وأيضا ما كان في آخر العمر فهو أفضل.
فإِن الأَشياءَ التي سبيلها أن تكون للناس في آخر أعمارهم هي أفضل، مثل
الحكمة والحلم وغير ذلك من الفضائل التي تكمل مع طول العمر.
وأَيضا الأَشياءُ التي إِذا فعلت أَو قبلت كان فعلُها حقيقتها أَعظم من
التي إِذا فعلت لم يكن فعلُها حقيقةَ تمامها. و أَرسطو يسمى التي إِذا
فعلت، كان فعلها حقيقتَها: " التي يتعمّد بها الحقيقة " ، ويسمى الأُخر: "
التي يتعمد بها المدح " ، أَعني التي ليس فعلُها حقيقتَها.
قال: وحد الأَشياء التي يعتمد بها المدح: أَنها التي إِذا فعلت بجهل أَو
بغلط لم تمدح أَصلا؛ والتي يتعمد بها الحقيقة: هي الأَشياءُ التي كيف ما
فعلت فقد حصلت على التمام.
قال: ولذلك كان حسن قبول الشيء الجميل آثر من فعل الشيء الجميل؛ لأَن فعل
الجميل، إِذا فعل عن غلط أَو جهل لم يقبل ولا مدح فاعله. وأَما حسن
الانفعال والقبول فكيف ما حصل فقد استفاد الخير منه القابل له.
وأَيضا ما أُوثر فعله لنفسه، وإِن لم يعلم به أَحد، آثر مما لا يختار إِلا
من جهة ما يعلم، كالحال في الصحة والجمال. فإِن الصحة مؤثرة بذاتها،
والجمال مؤثر للغير وأَيضا فإِن النافعة في أَشياء كثيرة فهي أَنفع،
كالنافعة في طول العمر وفي حسن العيش، أَعني العيش الرغد، وفي اللذات، وفي
اصطناع الخيرات. ولذلك ما يظن بالصحة واليسار أَنهما عظيمان، لأَنهما
يجمعان الخلو من الحزن والفعل بلذة، أَعني أَن الصحة هي سبب الفعل بلذة،
واليسار سبب الخلو من الأَحزان. وكل واحد من هذين على الانفراد فاضل
ومختار بنفسه، أَعني الخلو من الأَحزان والأَفعال اللذيذة. فإِذا اجتمعا
لامرئ جعلاه أَعظم من كل شيء، سواء علم ذلك منْ عِلمه أَو جهله مَنْ جهله.
لأَن هذه خيرات مستفادة بالحقيقة، لا من الخيرات التي يتعمد بها المدح.
ولكون اليسار سببا لدفع الأَحزان ظَن به أَنه السعادة قومٌ، وآخرون رأَوا
أَن السعادة هي أَن يقترن به شيء آخر.وذلك واجب من قِبَل أَنه أَحرى أَن
تكون السعادة ثابتة و مأْمونة الزوال. فإِنه ليس الضرر اللاحق لمن له
عينان ففقد إِحداهما كمن له عين واحدة ففقدها، لأَن الذي له عين واحدة سلب
أَحب مما سلب مَنْ له عينان. وكذلك إِن كانت السعادة في المال وفي شيء
آخر، لم يكن الضرر اللاحق عن سلب المال كالضرر اللاحق عن سلبه إِن كان هو
السعادة وحده.
قال: والكلام في هذه الأَشياء كلها هاهنا ليس هو على جهة التصحيح، وإِنما
الكلام فيها بالقدر الذي يحتاج إِليه الخطيب من ذلك. ويجب للخطيب أَبداً
متى أَتى بالنتائج من أَمثال هذه المقدمات أَن يرفدها بالمثالات المأْخوذة
من الناس الذين فعلوا تلك الأَفاعيل، فلحقهم النفع أَو الضرر. فلذلك ما
يجب للخطيب أَن يكون حافظا للقصص والأَخبار.
قال: فهذه هي الأَشياءُ التي يثبت بها أَن الشيءَ أَنفع أَو أَضر. وأَما
الأَشياءُ التي يكون بها الإِذن والمنع، فقد قيل فيها قبل هذا بما فيه
كفاية.
لكن أَهم وأَعظم ما فيها هو القول في الأَشياءِ التي بها يقدر
على جودة الإِقناع في السنن والإِشارة بالسنن التي لا يوجد أَنفع منها.
ولذلك قد يجب أَن نستقصي القول فيها هاهنا، فنقول: إِن الإِشارة بالسنن
النافعة والإِقناع التام فيها يتأَتى بمعرفة أَصناف السياسات والأَخلاق
والسنن التي تخص سياسة سياسة. وذلك أَن في كل واحدة من السياسات سننا
نافعة فيها، وهي السنن التي بها يكون خلاص تلك المدينة وقوامها. والسنن
النفيسة الخطيرة هي السنن العادلة، أَعني الموضوعة في العدل التي رسمها
الرئيس الأَول في تلك المدينة أَو المسلط عليها من قبل الرئيس الأَول. و
هذه السنن النفيسة، أَعني السنن العادلة، تختلف في السياسات بحسب اختلاف
غايتها، وعددها على عدد السياسات.
مثال ذلك أَن العدل في سياسة تغلب أَنه لا شيء على الرئيس إِذا لطم
المرؤوس. وفي سياسة الحرية، العدل في ذلك أَن يلطم الرئيس مثل اللطمة التي
لطمها.
والسياسات بالجملة أَربع: السياسات الجماعية، وسياسة الخسة، وسياسة جودة
التسلط، وسياسة الوحدانية وهي الكرامية.
وهذه السياسات كلها المقصود بالسنن الموضوعة فيها إِنما هو المدينة والكل
لا الشخص. د فأَما المدينة الجماعية فهي التي تكون الرياسة فيها بالاتفاق
والبخت لا عن استئهال، إِذ كان ليس في هذه المدينة لأَحد على أَحد فضل.
وأَما خسة الرياسة فهي التي يتسلط بها المتسلطون على المدنيين بأَداءِ
الإِتاوة والتغريم، لا على جهة أَن تكون نفقة للحماة والحفظة ولا عدة
للمدينة، على ما عليه الأَمر في السياسات الأُخر، بل على جهة أَن تحصل
الثروة للرئيس الأَول. فإِن جعل لهم حظا من الثروة كانت رياسة الثروة.
وإِن لم يجعل لهم حظا من الثروة كانت رياسة التغلب، وكانوا بمنزلة العبيد
للرئيس الأَول، وكانت محاماته عنهم بمنزلة محاماة الإِنسان عن عبيده.
وأَما جودة التسلط فهو التسلط الذي يكون على طريق الأَدب والاقتداء بما
توجبه السنة، فإِن الذين يشيرون بما توجبه السنة لهم هم متسلطون بجودة
التسلط.
وهذا هو التسلط الذي يحصل به صلاح حال أَهل المدينة والسعادة
الإِنسانية.ولذلك كان هؤلاءِ أَهل فضائل واقتدار على الأَفعال التي تصلح
المدينة، وأَهل حزم وتحرز مما شأْنه أَن يفسد المدينة من خارج أَو من
داخل. ولذلك سميت هذه المدينة بهذا الاسم. وهذا التسلط الذي ذكره صنفان:
رياسة الملك وهي المدينة التي تكون آراؤها وأَفعالها بحسب ما توجبه العلوم
النظرية. والثانية: رياسة الأَخيار وهي التي تكون أَفعالها فاضلة فقط.
وهذه تعرف بالإِمامية، ويقال إِنها كانت موجودة في الفرس الأَول فيما حكاه
أَبو نصر.
قال: وأَما وحدانية التسلط فهي الرياسة التي يحب الملك أَن يتوحد فيها
بالكرامة الرياسية وأَلا ينقصه منها شيء بأَن يشاركه فيها غيره، وذلك بضد
مدينة الأَخيار.
وهذه المدن ربما كانت السنن الموضوعة فيها محدودة غير متبدلة واحدة في
الدهور، على ما عليه الأَمر في سنتنا الإِسلامية، وربما كانت غير ذات سنن
محدودة، بل يفوض الأَمر فيها إِلى المتسلطين عليها بحسب الأَنفع في وقت
وقت، على ما عليه الأَمر في كثير من سنن الروم اليوم.
قال: وليس ينبغي أَن يخفى علينا من هذا الذي رسمنا به هذه السياسات غاية
كل واحدة منها، لأَنا إِذا عرفنا الغاية علمنا الأَشياء المختارة من أَجل
الغاية. فغاية السياسة الجماعية الحرية، وغاية خسة الرياسة الثروة، وغاية
جودة التسلط الفضيلة والتمسك بالسنة، وغاية الوحدانية الكرامة.
والسياسات التي ليس يوضع فيها سنن غير متبدلة فغاية واضعها هو التحفظ
والاحتراس من الخلل الواقع في السنن بتبدل الأَزمنة والأَمكنة.
وينبغي أَن تعلم أَن هذه السياسات التي ذكرها أَرسطو ليس تلفى بسيطة،
وإِنما نلفى أَكثر ذلك مركبة، كالحال في السياسة الموجودة الآن، فإِنها
إِذا تؤملت توجد مركبة من فضيلة وكرامة وحرية وتغلب.
قال: وإِذا كانت أَصناف السياسات معلومة عندنا، فهو بيّن أَنا
نستطيع أَن نعرف الأَخلاق والسنن التي تؤدي إِلى غاية كل واحدة من هذه
السياسات، أَعني النافعة فيها، وأَن نعتمد في أَنفسنا التخلق بتلك
الأَخلاق والتمسك بالصنف من السنن التي نروم الإِقناع فيها. فإِنه إِنما
تكون الأَقاويل التي يحث بها على السنن مقنعة، إِذا كان المشيرون بها ذوي
صلاح وحسن فعل، حتى تكون هذه الأَشياءُ المذكورة هاهنا معلومة لنا وموجودة
فينا. فإِنه إِذا وجد فينا الخلق الذي نحث عليه، كان قولنا في الحث عليه
أَشد إِقناعا. ولذلك ينبغي أَلا نشير إِلا بما هو موجود لنا أَو نحن
عازمون على أَن يوجد لنا. ومعلوم أَن الوقوف على السنن النافعة في الغاية
أَنه إِنما تستنبط على جهة التحليل من النظر إِلى الغاية. فقد تبين من هذا
القول من أَين تؤخذ المقنعات في النافع من السنن في سياسة سياسة، وكم
أَنحاءُ السياسات والسنن التي تحتذي فيها وذلك بحسب الكافي في هذه
الصناعة. وأَما القول في هذه الأَشياءِ على التحقيق ففي الأَقاويل المدنية.
القول في المدح والذم
قال: وأَما بعد هذا فنحن قائلون في الفضيلة والنقيصة والجميل والقبيح، لأَن هذه هي التي يمدح بها ويذم. ويلحق من تعريفنا هذه الأَشياء أَن نعرف الأُمور التي بها يثبت المرءُ فضيلة نفسه، إِذ كان ذلك هو الطريق الثاني من الطرق الثلاثة التي يقع بها الإِقناع كما تقدم من قولنا، وذلك أَنه نوع من المدح، أَعني أَن يكون بالأَشياءِ التي نقدر بها على مدح غيرنا نقدر بها أَنفسها على مدح أَنفسنا. وإِن لم يكن ذلك يتفق لجميع الأَشياء التي يمدح بها الغير، بل إِنما يكون ذلك بالفضيلة فقط وهي الأُمور الراجعة إِلى الاختيار.قال: ومن أَجل أَنه يعرض كثيرا أَن يمدح الناس الروحانيون بالفضيلة وبأَشياء غير الفضيلة، وليس يعرض هذا في مدح هؤلاءِ فقط، بل وفي مدح الأَشياءِ المتنفسة وغير المتنفسة، أَعني أَنها تمدح بأَشياءِ خارجة عن الفضيلة، فقد ينبغي أَن نقول هاهنا في الأَشياءِ التي تؤخذ منها المقدمات في المدح وبغير الفضائل ليكون القول في ذلك عاما.
فنقول: إِن الجميل هو الذي يختار من أَجل نفسه، وهو ممدوح وخير ولذيذ من جهة أَنه خير. وإِذا كان الجميل هو هذا فبين أَن الفضيلة جميلة لا محالة لأَنها خير وهي ممدوحة.
والفضيلة: هي ملكة مقدرة بكل فعل هو خير من جهة ذلك التقدير، أَو يظن به أَنه خير، أَعني الحافظة لهذا التقدير والفاعلة له، ولذلك كانت موجودة لكل فعل يقصد به نحو غاية ما، جليل القدر، عظيم الشأْن في حصول تلك الغاية عنه.
فأَما أَجزاءُ الفضيلة: فالبر أَي العدل العام والشجاعة والمروءَة والعفة وكبر الهمة والحلم والسخاء واللب والحكمة. وهذه الفضائل منها ما هي فضائل في ذات فقط، ومنها ما هي فضائل من جهة أَنها تفعل في أُناس آخرين. وهذه التي تفعل في أُناس آخرين تكون أَعظم عند قوم منها عند آخرين، وفي حال دون حال. مثال ذلك أَن فضيلة الشجاعة آثر في وقت الحرب منها في وقت السلم. وأَما فضيلة العدل فمؤثرة في السلم والحرب جميعا. وفضيلة السخاءِ والمروءَة عند المحاويج آثر منها عند غير المحاويج. وإِنما تنفصل فضيلة المروءَة من السخاءِ بالأَقل والأَكثر،لأَن فعل كلتيهما هو في المال، لكن المروءة هي فعل أَكثر من فعل السخاءِ.
فأَما البر فهو فضيلة عادلة يعطى الفاضل بها لكل امرئ من الناس ما يستحق وذلك بقدر ما تأْمر به السنة. والجور هو الخلق الذي يأْخذ به المرء الأَشياء الغريبة التي ليس له أَن يأخذها في السنة.
وأَما الشجاعة ففضيلة يكون المرءُ بها فعالا للأَفعال الصالحة النافعة في الجهاد على حسب ما تأمر به السنة حتى يكون بفعله ذلك خادما للسنة، وأَما الجبن فضد هذا.
وأَما العفة ففضيلة يكون بها المرءُ في شهوات البدن على مقدار ما تأمر به السنة، والفجور ضد هذا.
وأَما السخاءُ ففضيلة تفعل الجميل المشهور في المال، والدناءة ضد هذا.
وأَما كبر الهمة ففضيلة يكون بها حسن الأَفعال العظيمة. وصغر النفس والنذالة ضدها.
وأَما اللب ففضيلة العقل الذي يكون به حسن المشورة والروية مع وجود الفضائل الخلقية له التي هي من صلاح الحال.
فهذا هو القول في الفضيلة وأَجزائها بقدر ما يحتاج إِليه في هذه
الصناعة. وأَما سائر الأَشياءِ التي يمدح بها مما عدا الفضيلة فليس يعسر
الوقوف عليها. وذلك أَنه معلوم أَن فاعلات الفضائل مثل التأَدب والارتياض
بالأَشياءِ التي بها تحصل الفضائل هي أَمور حسان وممدوح بها. وأَما
الأَشياء التي توجد في الفضائل أَنفسها، أَعني الأَعراض التي توجد فيها
والأَشياءَ التي توجد تابعة للفضائل فهي التي يقال فيها الآن وهي علامات
الفضائل. وأَعراضها اللاحقة لها وأَفعالها إِنما يمدح بها إِذا كانت حسنة
محمودة، فإِن كثيرا من أَفعال الفضائل قد لا يمدح بها، وكذلك كثير من
الأَعراض. فمثال الأَفعال والأَعراض التي هي محمودة أَفعال الشجعان في
الحرب أَو مَنْ فعل في الحرب فعلهم، وإِن لم تكن لهم ملكة الشجاعة.وكذلك
الأَعراض التي تلحق الشجعان مما يمدح بها. ومثال الأَفعال التي لا يمدح
بها في وقت ما بذلُ المال، فإِنه فعل من أَفعال السخاءِ. لكن ربما كان ذلك
الفعل على جهة التبذير. ومثال الأَعراض التي لا يمدح بها انفعال المرءِ عن
العدل وقبوله إِياه، وذلك أَن فعل العل ممدوح، وأَما الانفعال عنه فليس
بممدوح، لأَنه يظن به أَنه مهانة وضيم. وبالجملة فأَفعال الفضائل إِنما
تكون ممدوحة إِذا كانت مقدرة تقدير العدل. ومما يمدح بها الأَفعال العظيمة
الشاقة التي جزاؤها الكرامة فقط. فإِن الأَفعال التي يكون جزاؤها الكرامة
خير من الأَفعال التي جزاؤها المال. ولذلك إِذا كان فعل يجازي عليه
بالأَمرين جميعا، ففَعَلهُ فاعلٌ من أَجل الكرامة فقط، مدح به وكل مايفعله
المرءُ من الفضائل لا من أَجل نفسه مدح به. وفعل الأَشياءِ التي هي خيرات
بإِطلاق كذلك مما يمدح به. ولأَشياء التي في طبيعتها خيرات، وإِن كانت
ضارة للفاعل، يمدح بها أَيضا، مثل فعل العدل. فإِن العادل كثيراً ما يستضر
به. والأَفعال التي تختص بإِكرام الأَموات ممدوحة لأَن الأَفعال التي تكون
للأَحياءِ إِنما يقصد منها المرءُ أَكثر ذلك منفعة نفسه. وبالجملة فكل فعل
كان المقصود به الغير ولم يكن ينتفع به الفاعل له أَو كان يلحقه منه ضررٌ
فهو ممدوح به. والفعل الذي يكون إِلى المحسنين إِلى الناس ممدوح به أَيضا،
لأَن هذا هو عدل، إِذ كان ليس ينتفع به الفاعل له. ومما يدل على أَن
الإِنسان ذو فضيلة أَن لا يفعل الأَفعال التي يفتضح بها أَهل الفواحش وأَن
يؤدّبهم بالقول والفعل. وكذلك نصرة ذوي الفضائل ومحمدتهم مما يمدح به.
والخجل عند ذكر القبائح مما قد يدل على الفضيلة، لأَنه يظن به أَن الحياءَ
يمنعه عن إِتيان تلك الرذيلة. وقد يكون أَيضا عدم الحياء عند ذكر الفواحش
علامة يمدح بها، وذلك أنه قد يظن أَن الإِنسان إِنما يستحي عند ذكر
القبائح إِذا كان قد فعلها أَو نالها أَو هو مزمع أَن يفعلها. مثل ما حكى
أَرسطو أَنه عرض لامرأَة مشهورة بالحكمة عندهم، وذلك أَن إِنسانا مشهورا
عرّض لها بالقبيح، بأَن قال لها: إِني أُريد أَن أَقول قولا يمنعني عنه
الحياء، فحلمت عنه ولم تجبه بقول قبيح ولم يدركها من ذلك تأَلم ولا
انفعال، لأَنها كانت ترى لمكان فضيلتها أَن أَحدا لا يعرّض لها لا بمثال
ولا بقول كلي، وهما صنفا التعريض، لكنها في تلك الحال جعلت تنص الفضائل
وتمدح أَهلها وتتعصب لهم وتحامي عنهم. وكان أَيضا مَنْ معها لم يأْنفوا
أَيضا لقول ذلك ولا لتعريضه لعلمهم أَن مثلها لا يتهم بمثل هذا.
قال: ولذلك كان التعصب للأَشياءِ التي تكسب المجد والمحاماة عنها قد تجعل
المتعصب لها والمحامي عنها من أَهل الفضائل التي لا تحصل للإِنسان إِلا
بمجاهدة كبيرة للطبيعة مثل العفاف والشجاعة وغيرها وذلك إِذا صارت له ملكة
بترداد فعلها والتعصب لها والمحاماة عنها كما عرض لهذه المرأة التي
اقتصصنا ذكرها مع ذلك الرجل. وذلك أَن أمثال هذه الأَفعال قد يصير بها
الإنسان من أَهل الفضائل التي لا تحصل للإِنسان إِلا بمجاهدة كبيرة.
قال: والإِنعام على الغير إِذا لم يستفد المنعم منه شيئا هو مما
يمدح به. ولذلك ما كان العدل والبر قد يمدح بهما الإِنسان من جهة أَنهما
نافعان كما يمدح بهما من جهة ما هما جميلان. والانتقام أَيضا من الأَعداءِ
ولا يرضى عنهم في حال مما يمدح به. فإِن الانتقام منهم هو جزاء، والجزاءُ
عدل، والعدل جميل. ومحبة الغلبة أَيضا ومحبة الكرامة مما يمدح بهما
لأَنهما علامتان تدلان على إِثار الفضائل لا لمكان اكتساب مال بهما. أَما
محبة الغلبة فتدل على إِيثار الشجاعة. وأَما محبة الكرامة فعلى إِيثار
جميع الفضائل. ولذلك كانت الفضائل الأَثيرة المختارة هي التي ليس يقصد بها
مقتنيها إِلى اكتساب مال لأَن ذلك يدل على شرف الفضيلة. ومن الأَفعال التي
يمدح بها التي شأنها أَن يبقى ذكرها محفوظا أَبدا عند الناس. ومن الأَشياء
التي يمدح بها الهيئات المحمودة عند قوم التي يجعلونها علامة لذوي الشرف
مثل توفير الشعور عند اليونانيين، فإِنه يدل على الشرف، إِذ كان ليس كل
أَحد يسهل عليه توفير شعره، لأَن الموفورى الشعور لا يعملون عمل من ليس
بموفور الشعر ولا يمتهنون بأَي مهنة اتفقت. والأَزياءُ التي كانت تتخذ
عندنا هي من هذا النوع الذي ذكره أَرسطو.
قال: ومن الشرف أَلا يحتاج الإِنسان إِلى آخرين، بل يكون مكتفيا بنفسه.
قال: وقد ينبغي أَن نأخذ في المدح والذم الأُمور القريبة من الفضائل
والنقائص، وهي النقائص التي قد توجد عنها أَفعال الفضيلة، أَو الفضائل
التي قد توجد عنها أَفعال النقائص: فيمدح بالنقائص التي توجد عنها أَفعال
الفضيلة بأَن يوهم أَنها فضائل من أَجل أَن تلك الأَفعال هي من أَفعال
الفضائل. وكذلك يوهم في الفضائل أَنها نقائص من أَجل أَنه عرض أَن وجد
عنها أَفعال النقائص. فمثال النقائص التي توجد عنها أَفعال الفضائل فتوهم
أَنها فضائل: العىّ الذي قد يكون عنه أَفعال الحليم، فيوهم به أَنه حليم،
والبله الذي قد توجد عنه أَفعال ذوي السمت فيوهم بذلك أَنه ذو سمت. وكذلك
العديم الحس قد يوهم فيه أَنه عفيف إِذ كان قد يوجد له فعل العفيف بالعرض.
وكذلك المتهور قد يوهم فيه أَنه شجاع، والسفيه أَنه كريم.
ومثال ما يوهم به أَنه نقيصة، وليس بنقيصة، ما يعرض للكبير الهمة من أَن
يتجافى عن الأُمور اليسيرة فيظن به أَنه يغلط وينخدع. والكبير الهمة إِنما
يصنع ذلك في الأُمور اليسيرة التي ليس يلحقه منها خوف كبير ولا ضرر شديد.
وذلك أَيضا في الموضع الذي يحسن فيه أَن يتغافل عنها. وقد يوهم أَيضا هذا
الموضوع عكس هذا، وهو أَن يقال في المنخدع إِنه كبير الهمة. ومما يمدح به
أَن يكون المرءُ يُعطي أَصدقاءه وغير أَصدقائه ومن يعرف ومن لا يعرف،
لأَنه يظن أَن شرف فضيلة السخاءِ هو بذل المال للكل.
قال: وقد ينبغي أَن يكون المدح بحضرة الذين يحبون الممدوح، كما قال سقراط:
إِنه يسهل مدح أَهل أَثينية بأَثينية. وينبغي أَن يمدح كل إِنسان بالذي هو
ممدوح عند قومه وأَهل مدينته، إِذ كان ذلك يختلف.
قال: ومن المدح بالأَشياءِ التي من خارج مدحُ الآباءِ وذكرُ مآثرهم
المتقدمة، ومدح المرء بما تسمو إِليه همته من المراتب وإِنه ليس يقتصر على
ما حصل له منها. والرجل الكبير الهمة الذي لا يقتصرب بهمته على ما نال من
المراتب يمدح بهذين الأَمرين من خارج، أَعني بفضائل آباؤه وبما يؤمل أَن
يسمو نحوه، كما يقال: من أَي مآثر ابتدأَ من قبل آبائه، وإِلى أَي مآثر
ينتهي من قبل همته. وأَما الذي لا يسمو بهمته إِلى نيل أَكثر مما حصل له
من المرتبة، فإِنما يمدح من الأَمرين الذين من خارج بأَبآئه فقط. وكأَنه
يرى هاهنا أَن المدح بمناقب الآباءِ ليس ينبغي أَن يقتصر عليه دون أَن
يمدح بفضيلة ذاته، كما قال الشاعر:
لسنا وإِن كرمت أَوائلنا ... يوما على الأَحساب نتكل
نبني كما كانت أَوائلنا ... تبني ونفعل مثل ما فعلوا
وإِنه قد يقتصر بالمدح على الفضيلة دون ذكر الآباءِ كما قال:
نفس عصام سوّدت عصاما
قال: وإِنما يكون المدح على الحقيقة بالأَفعال التي تكون عن
المشيئة والاختيار، فإِن الفعل الذي يكون بالمشيئة والاختيار هو الفعل
الفاضل. والذي يمدح بالأَشياءِ التي تكون بالاتفاق أَو بالعرض من أَجل أَن
لها إِذا اقترنت بالفضائل تزيينا لها وتفخيما بمنزلة الحسب المقترن إِلى
الفضيلة وجودة البخت المقترن بأَفعال الفضائل. وإِنما يدخل في المدح
الأَفعال التي تكون باتفاق والأَعراض التي تقترن بالعرض مع الأَفعال التي
تكون بالمشيئة متى تكررت مرارا كثيرة على صفة واحدة حتى أَوهمت أَنها
بالذات، وذلك أَنه إِذا عرض لها ذلك ظن بها أَنها علامة للفضيلة، مثل أَن
يخجل الإِنسان مرارا كثيرة بالاتفاق في مواضع يمدح الخجل فيها.
وإِنما دخلت هذه الأَشياءُ في المديح لأن المديح هو قول يصف عظم الفضيلة،
وهذه الأَشياءُ هي مما تعظم بها الفضيلة. وإِذا استعملت هذه الأَشياءُ في
المديح، فينبغي أَن تستعمل على أَنها حدثت عن الروية. والأَشياءُ التي
بالاتفاق: منها أَشياء ليس الإِنسان سببها لا بالذات ولا بالعرض، مثل
الحسب والمنشأ الفاضل، ومنها أَشياء تعرض عن الأَفعال التي تكون عن
الروية. فأَما الاتفاقات المتقدمة على الإِنسان فتؤخذ في تقرير الفضيلة
وتثبيتها، مثل ما يقال في المدح: إِن الخيار يولد في الخيار، وفي الذم:
إِن الحية تلد الحية. والأَفعال بالجملة هي التي عليها يحمد الفاعل. وأَما
آثار الأَفعال فهي دلائل على الفعل. وإِنما يمدح بها إِذا أَثبتنا منها
الفعل.
قال: وجودة البخت التي قيل فيما تقدم إِنها السعادة على ما يراه الجمهور
هي وسائر الأَشياء الاتفاقية التي يمدح بها واحدة في الجنس، وليست هي
والفضائل واحدة بالجنس. بل كما أَن صلاح الحال جنس للفضيلة، أَعني محيطا
بها، كذلك ما يحدث بالاتفاق جنس يحيط بالسعادة. وهذان الجنسان، أَعني
الفضائل وما بالاتفاق، يدخلان جميعا في باب المدح وفي باب المشورة، لكن من
جهتين مختلفتين. وإِنما كان الأَمر كذلك، لأَنا إِذا عرفنا الأَشياءَ التي
يجب أَن تفعل، فقد عرفنا الأَشياءَ التي إِذا فعلت مدح بها الإِنسان.
ولذلك إِذا ذكرت هذه الأَشياء ذكرا مطلقا، أَمكن أَن تدخل في المشورة وفي
المدح، وذلك بزيادة الجهة التي بها تدخل في المشورة أَو الجهة التي بها
تدخل في المدح. وذلك مثل ما يقول القائل: إِنه ليس ينبغي أَن يوجب العظم
والفضل للأَشياءِ التي تكون للإِنسان بالعرض، بل للأَشياءِ التي تكون عن
رويته واختياره. فإِذا زيد إِلى هذا: فلذلك ليس ينبغي أَن يمدح الذين
سعادتهم بالبخت، وإِنما ينبغي أَن يمدح الذين سعادتهم عن روية واختيار
كفلان، كان داخلا في باب المدح. وإِذا زيد إِلى هذا: فلذلك لا ينبغي أَن
تطلب الأَشياء التي تكون عن الاتفاق بل الأَشياء التي تكون عن الروية، دخل
في المشورة. والأَشياءُ الاتفاقية قد يمكن أَن تستعمل في المديح تارة وفي
الذم أُخرى، فإِن ظنون الناس فيها مختلفة. فإِن قوما يرون أَن الخيرات
التي تكون بالاتفاق ليس ينبغي أَن يمدح بها، إِذ كانت شيئا غير محصل ولا
مكتسب للإِنسان؛ وقوم يرون أَنه يجب أَن يمدح بها وأَنها تدل على عناية
إِلاهية بالذي تعرض له. وأَما الأَشياءُ التي عن الاختيار، فالممدوح منها
يمدح به أَبداً، والمذموم منها يذم به أَبداً.
قال: وينبغي أَن يستعمل في المدح الأَشياء التي يكون بها تعظيم
الشيء وتنميته، وهو أَن يخيل في الشيءِ أَنه بالقوة أَشياء كثيرة، وذلك
إِذا قيل إِنه أَول من فعل هذا، كما قيل في قصة هابيل وقابيل، أَو إِنه
وحده فعل هذا، أَو إِنه فعل في زمان يسير ما شأْنه أَن يفعل في زمان كثير،
أَو إِنه فعل فعلا كبيرا. فإِن هذه كلها إِنما تفيد عظم الفعل. وكذلك إِذا
قيل إِنه فعل في زمان يعسر فعله، وذلك إِذا كان بحسب ما يشاكل إِنسانا
إِنسانا. ثم إِنه إِن كان الفاعل ممن يقتدى به في أَفعاله وأَقواله مرارا
كثيرة فإِن فعله عظيم، كما قيل: إِنكم أَيها الرهط أَئمة يقتدى بكم.
والأَفعال التي يقتدى بها ليست هي الأَفعال التي تكون بالاتفاق، بل
الأَفعال التي تكون عن المشيئة والروية. وهذه الأَشياءُ قد يمكن أَن تدخل
في المشورة، أَعني الأَشياءَ التي تعظم الشيء، مثل أَن يشار على المرءِ
أَن يتشبه بالممدوح الأَول في ذلك الجنس، أَو يتشبه به في المدح؛ أَو يشار
عليه أَن يكون من جملة الممدوحين الذين لا ينازع أَحد في حمدهم، مثل الذين
يمدحون في الأَسواق، أَو يتشبه بهم في المدح. ومما يعظم الممدوحين أَن
يقاسوا بالذين يفعلون أَضداد أَفعالهم، وذلك عند ذكر أَفعالهم الفاضلة.
قال: والذين شأْنهم أَن يتشبهوا بالممدوحين الذين في الغاية، ويقاسوا
أَنفسهم معهم دائما، فقد ينبغي أُن يشبهوا بأُولئك، وأَن يجروا مجراهم في
المدح، وإِن لم يكونوا وصلوا مراتبهم، فإِن فضائلهم في نمو دائم. ومقايسة
الإِنسان نفسه مع غيره لا تصح إِلا من الرجل الفاضل، لموضع حب الإِنسان
لنفسه، فهو يرى نقائصه أَقل من نقائص غيره وإِن كانت أَعظم، ويرى فضائله
أَكثر وإِن كانت أَصغر. ولذلك ليس كل أَحد يستطيع المقايسة، وإِنما
يستطيعها الفضلاءُ من الناس، مثل ما حكى أَرسطو عن سقراط أَنه كان يقايس
بينه وبين غيره، ويجرى الأَحكام على أَخلاق نفسه، بمعنى أَنه كان ينظر
بينه وبين غيره، فإِن وجد فيه فضيلة أَثاب نفسه عليها، وإِن وجد فيه رذيلة
عاقب نفسه عليها. والمقايسة النافعة لمن يريد أَن يتزيد في الفضائل إِنما
ينبغي أَن تكون بالممدوحين جدا. وقد يدل على أَن أَمثال هؤلاءِ ممدوحون،
أَعني الذين فضائلهم في نمو دائم، أَن الذين أَجهدوا أَنفسهم في أَن
يبلغوا مبلغ الفاضلين، فعجزوا عن ذلك، فهم ممدوحون عند الجمهور. وهو بيّن
أَن تعظيم الشيء داخل في المدح. فإِن التعظيم للشيءِ تشريف له، والتشريف
من الأُمور التي يمدح بها. وينبغي إِذا أُريد التعظيم بالتشبيه أَن يشبه
بكثير من المحمودين، فإِن في هذا الفعل تشريفا للممدوح ودلالة للجمهور على
فضيلته. وجملة القول في الأَنواع المشتركة لأَجناس الأَقاويل الثلاثة أَن
التعظيم، وإِن كان مشتركا لأَجناس الأَقاويل الخطبية الثلاثة، فهو أَخص
بالمدح والذم، لأَنه إِنما يمدح الإِنسان أَو يذم بالأَشياءِ الموجودة
المعترف بوجودها. وتعظيم الشيء أَخص بالموجود منه بالمعدوم. ولذلك قيل قد
ينبغي للمادح أَن يصف جلالة الشيء وبهاءه وزينته. وأَما استعمال العلامات
والمثالات فهو أَخص بالمشورة، لأَن من الأُمور المتصرمة التي قد سلفت نحدس
على التي ستكون. وإِعطاء السبب والعلة من الأَشياء التي قد سلفت نحن له
أَكثر قبولا وتعظيما لانقضائه وتصرمه. وأَما معرفة العدل والجور فهو خاص
بالمشاجرية.
وبالجملة: فجميع المدح والذم إِنما يكون بالمقايسة بمن سلف من المحمودين
والمذمومين. وقد ينبغي للمادح والذام أَن يعلم بحضرة مَنْ يكون المدح أَو
الذم، أَعني أَن يمدح بحضرة الأَصدقاءِ، ويذم بحضرة الأَعْداءِ. كما ينبغي
له أَن يعلم المواضع التي يأْخذ منها المدح والذم وهي التي سلف ذكرها، وهي
الفضائل وفاعلاتها وعلاماتها وأَعراضها. وهو بيّن أَن مما ذكرناه من حدود
هذه الأَشياءِ تعرف حدود أَضدادها، إِذ كان الضد يعرف من ضده. وإِذا كانت
هذه معروفة لنا من أَضدادها، وكان الذم إِنما يكون بأَضداد تلك، فهو بيّن
أَنا قد عرفنا من هذا القول ليس الأَشياء التي يكون بها المدح فقط، بل
والأَشياء التي يكون بها الذم.
القول في الشكاية والاعتذار
قال: وإِذ قد تكلمنا في الأُمور المشورية، وفي المدح والذم، فقد
ينبغي أَن نتكلم في الجنس الثالث من موضوعات هذه الصناعة وهو الشكاية
والاعتذار، وذلك يكون بأَن نخبر من كم صنف من أَصناف المقدمات تأْتلف
القياسات التي تعمل على طريق الشكاية وطريق الاعتذار، ونعرف ماهية واحد
واحد من تلك الأَصناف. وأَصناف المقدمات التي تعمل منها أَقاويل الشكاية
هي بالجملة ثلاثة أَصناف: أَحدها المقدمات المأْخوذة من الفاعل، أَعني
الجائر. والصنف الثاني المقدمات المأْخوذة من المفعول، أَعني المجور عليه.
والثالث المقدمات المأْخوذة من الفعل نفسه. أَما المأْخوذة من الفاعل
فمعرفتها تكون بأَن تحصى الأَشياء التي إِذا كانت في الإِنسان ظن به أَنه
قد جار، وأَن نخبر ما تلك الأَشياء. وأَما المأْخوذة من المفعول به فأَن
نحصى أَيضا الأَشياء التي إِذا كانت في الإِنسان كان معدا لأَن يجار عليه.
وأَما المأْخوذة من الفعل فأَن نخبر أَيضا بماذا من الأَفعال يكونون
جائرين، وبأَي أَحوال من أَحوال الأَفعال يتأَتى الجور، وكيف يتأَتى ذلك
لهم.
قال: وقد ينبغي قبل ذلك أَن نخبر ما الجور، ثم نصير إِلى القول في واحد
واحد من هذه الأَشياءِ الثلاثة، فنقول: إِن الجور: هو إِضرار يكون طوعا
على طريق التعدي للسنة. والسنة على ضربين: منها خاصة، ومنها عامة.
والسنن الخاصة هي السنن المكتوبة التي لا يؤمن أَن تنسى إِن لم تكتب، وهي
التي تخص قوما قوما وأُمة أُمة.
وأَما العامة فهي السنن الغير المكتوبة التي يعترف بها الجميع، مثل بر
الوالدين وشكر المنعم.
والفعل يكون طوعا إِذا فعله الفاعل عن علم به غير مكره عليه إِكراها محضا،
أَو غير ذلك مما يذكر بعد، ويكون مع هذا ذلك الفعل مما يهواه ويتشوقه.
والأَفعال التي تكون طوعا: منها ما يكون عن روية واختيار متقدم لها، ومنها
ما يكون لا عن روية متقدمة، لكن عن ضعف روية، لمكان خلق رديء أَو عادة.
وهو بيّن أَن الذي يفعل الشيء عن روية متقدمة أَنه يفعله عن علم. وإِذا
كان الأَمر هكذا، فهو بيّن أَن الذين يفعلون عن الروية أَو عن ضعف الرأي
أَفعالا ضارة أَو غاشة، أَعني مختلطة من ضرر ومنفعة، يتعدون فيها السنة،
أَنهم جائرون، وأَن ذلك شر منهم أَو ضعف رأي. وأَن من كانت فيه واحدة من
الأَشياءِ التي هي سبب ضعف الرأي، وكان هو سبب وجود ذلك الشيء فيه أَنه
جاهل شرير جائر، مثل الجور في المال الذي يكون سببه الرغبة فيه، والجور في
اللذات الذي سببه شدة الشبق والشره، والكسل الذي هو سبب الجور في أَشياء
كثيرة، وكذلك الجبن. ولذلك قد يفارق الجبان أَصحابه ويسلمهم عند أَدنى شدة
تنزل به. وكذلك محب الكرامة قد يفارق أَصحابه من أَجل حب الكرامة. وكذلك
المحبون للغلبة يفارقون أَصحابهم من أَجل حب الغلبة. والسريع الغضب وذو
الحمية أَيضا والأَنفة قد يضر بأَصدقائه من أَجل عار يلحقه. وأَما الجاهل
الأَحمق فإِنما يفعل الجور من أَجل أَنه يلتبس له العدل بالجور. وأَما
الوقاح فيفعل الجور لقلة رغبته في الحمد.
وكذلك ما أَشبه هذا من الأَحوال التي تكون سببا للجور لا عن روية. وهذه
الأَحوال تعرف من قبل ما تقدم من ذكر الفضائل، ومما يأتي بعد من ذكر
الانفعالات، وأَنها بالجملة: إِما خلق رديء وإِما انفعال رديء. والأَخلاق
الرديئة تعرف مما تقدم، أَعني من معرفة أَضدادها، وهي الفضائل.
والانفعالات تعرف مما يقال بعد في المقالة الثانية.
قال: وإِذا تقرر هذا، فقد انتهى القول بنا إِلى أَن نخبر من أَجل
ماذا يجور الجائرون، وكيف يكون للجائرين أَن يجوروا، وفي أَي الأَشياءِ
يجورون. غير أَنه يجب أَن نبتدئ فنبيّن أَيّ الأَشياء التي من أَجلها
يجورون، أَعني الأَشياء التي إِذا اشتاقوها جاروا، أَو إِذا كرهوها جاروا
أَيضا. وهو بيَّن أَن القول في الشكاية ينبغي أَن يقدم على القول في
الاعتذار، لأَن الذي يريد أَن يشكو يجب أَن يكون معروفا عنده الأَشياء
التي يُشكى منها، وكم هي، وأَي هي. وأَما مواضع الاعتذار فليست محدودة
كمواضع الشكاية. وإِنما تتحدد مواضع الاعتذار بحسب مواضع الشكاية.
والشكاية أَمر وكيد في الاجتماع الإِنساني. ولذلك ترى كثيرا من الناس،
إِذا لم يشكوا، أَضروا بأَقربائهم وإِخوانهم. وكل فاعل شيئا على طريق
الجور، فإِما أَن يفعله من أَجل نفسه ومن ارادته واختياره فقط، وإِما أَلا
يفعله بحسب نفسه واختياره. وهذا إِما أَن يفعله باتفاق وهو الذي يسمى هفوة
وفلتة، وإِما أَن يفعله باضطرار: منه ما يفعله من أَجل طبيعته مثل أَن
يكون سيء الخلق بالطبع، ومنه ما يفعله من أَجل قاسر من خارج، أَعني أَن لا
يكون الفعل الذي يفعله طوعا، بل عن وعيد من خارج أَو تهديد وما أَشبه ذلك.
والذي يفعله من تلقاءِ نفسه هو الذي تكون نفسه ومفردا علة كونه، لا شيء
آخر يقترن به من خارج. والذي يفعله من تلقاءِ نفسه: منه ما يكون من قبل
عادة رديئة أَو خلق رديء، ومنه ما يكون بحسب شهوة وشوق. والذي يكون بحسب
الشوق: منه ما يكون بحسب شوق مظنون نطقي، ومنه ما يكون بحسب شوق خيالي.
والذي يكون بحسب شوق خيالي: منه ما يكون بحسب شوق غضبي، ومنه ما يكون بحسب
شهوة. وإِذا كان هذا هكذا، فالجائرون يجورون لا محالة لمكان سبعة أَسباب:
أَحدها لمكان الاتفاق، والثاني لمكان الطبيعة، والثالث لأَجل الاستكراه،
والرابع لأَجل العادة والخلق، والخامس من أَجل النطق، والسادس من أَجل
الغضب، والسابع من أَجل الشهوة؛ وكلها ما عدى الذييكون عن النطق هي أَقسام
ضعف الرأي الذي تقدم.
قال: وليست قسمة الأَفعال الجائرة من طريق الأَسنان والهمم والجدود قسمة
ذاتية. لأَن الغلمان وإِن كان جورهم أَكثر فليس ذلك أَولاً وبالذات من جهة
ما هم غلمان، بل من جهة أَن الغلمان يكونون غضوبين أَو شهوانيين. وكذلك
يعرض للفقراءِ أَن يشتاقوا إِلى المال أَكثر من الأَغنياءِ بسبب فاقتهم،
كما يعرض للأَغنياءِ أَن يشتاقوا إِلى المال لمكان اللذات الغير الضرورية
أَكثر من الفقراءِ. فمتى نسب الأَغنياء أَو الفقراء إِلى الجور في جنس ما
من الأَجناس فليس سبب ذلك القريب الغنى والفقر، بل الشهوة والخلق الذي
تكتسب النفس عن الفقر والغنى. وكذلك الحال في الهمم، أَعني أَنه إِن نسب
شيء منها إِلى الجور فليس ذلك بذاته وأَولا، بل من قبل أَن الهمم تكون
سببا لواحد أَو لأَكثر من واحد من تلك الأَسباب السبعة التي هي أَولا
وبالذات أَسباب الجور. ولذلك كان الأَبرار والفجار وسائر الذين يقال فيهم
إِنهم يفعلون بحسب هممهم إِنما يفعلون: إِما عن واحد من تلك الأَسباب
السبعة المتقدمة أَو عن أَكثر من واحد، وإِما عن أَضدادها، وهم ذوو الهمم
الجميلة؛ أَعني أَن الفجار يفعلون عن تلك الأَسباب، والأَبرار عن
أَضدادها. مثال ذلك أَن العفيف تلزمه شهوات فاضلة لذيذة، والفاجر تلزمه
شهوات رديئة. ولذلك قد يجب أَن يترك هذا النحو من التقسيم هاهنا وتذكر هذه
الأَشياء بأَخرة على أَنها أَسباب لهذه الأَسباب السبعة، لا على أَنها
أَسباب أُولى لأَفعال الجور. وأَما التي هي أَسباب بالعرض فينبغي أَن
نتجنب ذكرها هاهنا أَصلا، مثل أَن يكون المرءُ أَسود أَو أَبيض أَو ضخما
أَو نحيفا. فإِن هذه قد يلحقها بالعرض اختلاف الأَخلاق والشهوات. وإِنما
ينبغي أَن نذكر هاهنا من أَسباب هذه الأَشياء، أَعني الأَسباب السبعة التي
عددنا قبل، الأَعراض التي تغير الخلق بالذات سواء كان نفيسا أَو جسمانيا
أَو من خارج مثل الشيخوخة والصّبا والفقر والغنى. فإِن المرءَ إِذا افتقر
ظن بنفسه صغر القدر واستحيا من كل شيء يصنعه، وإِذا أَثرى ظن بنفسه العظم
ولم يستح من شيءٍ. لكن هذه سيقال فيها فيما بعد.
وأَما هاهنا فنرجع إِلى ما كنا بسبيله، فنقول: إِنه إِذا تبينت
الأَسباب الفاعلة للجوْر، تبينت الأَسباب الغائية لواحد واحد منها. أَما
الذين يجورون بالاتفاق فليس لهم غاية محدودة، ولذلك لا يكون جوْرهم دائما
ولا أَكثريا ولا يكون عن ملكة وهيئة ثابتة. وهذا معلوم من قبل طبيعة ما
بالاتفاق. وذلك أَن الاتفاق إِنما يكون سببا للأَشياءِ على الأَقل، على ما
قيل في كتاب البرهان. وأَما الجور الذي يكون عن طبيعة الجائر وغريزته فهو
عن هيئة ثابتة راسخة.
والأَفعال التي تصدر عن هذه الطبيعة هي أَبداً بصفة واحدة، وذلك إِما
دائما وإِما أَكثريا. وغايتها هي غاية الانفعالات الرديئة التي سيقال فيها
فيما بعد. وأَما ما كان منه عن حالة خارجة عن الطبع مثل الجنون وغير ذلك
من الآفات التي ليست تجرى مجرى الطبع فقد يظن أَنه منسوب إِلى الاتفاق،
وليس ينسب إِلى شيءٍ بالذات. وأَما الأَفعال التي تكون عن الإِكراه، أَعني
التي هي باختيار ولكن مبدؤها الإِكراه، فغايتها هي غاية الأَفعال الجائرة
التي تكون باختيار؛ إِذ كان الإِكراه يعرض لجميع الأَفعال التي تفعل
باختيار. وأَما الجور الذي يكون عن الروية والفكر فغايته: إِما الأَشياء
التي يظن بها أَنها نافعة وهي الأَشياءُ التي ذكرت في باب المشورة، وذلك
هو الشيء الذي يظن به أَنه خير إِما من جهة أَنه يظن به أَنه غاية نافعة
أَو أَنه نافع في الغاية النافعة، وإِما الأَشياءُ اللذيذة.
ولذلك قد يفعل الفجار النافعة كثيراً من أَجل اللذة.
وأَما الجور الذي يكون عن الغضب فغايته الأَخذ بالثأر. والأَخذ بالثأر هو
شيء غير العقوبة، لأَن العقوبة إِنما تكون لمكان المعاقب وذلك إِما
للأَصلح له أَو للأَصلح للمدينة، أَو لمكان الالتذاذ بنفس معاقبته. وهذه
هي المعاقبة السبعية. وأَما الثأر فإِنما هو قصد مساواة الجناية التي جنى،
أَعني أَن يجني عليه بمثل ما جنى. وهذه هي الغاية من الثأر التي يعرضها في
نفسه الآخذ به. فأَما معرفة حد الغضب ما هو ومعرفة لواحقه فسيقال فيه بعد،
وذلك عند ذكر الانفعالات. وأَما التي تكون بالخلق أَو بالعادة فإِنما تكون
لمكان اللذة، وكذلك التي تكون عن الشهوة. ولذلك جميع الأَشياء التي يظن
بها أَنها لذيذة فإِنما تفعل من قبل سبب واحد من هذه الأَسباب الأَربعة
التي يفعل بها المرءُ من تلقاءِ نفسه، أَعني الروية والغضب والخلق والعادة
والشهوة.
واللذات التي تكون عن الخلق والعادة قد تكون على وجوه شتى، أَعني أَن منها
ما هو طبيعي، ومنها ما ليس هو طبيعيا، وإِنما يلتذ بها من قبل العادة.
وبالجملة فجميع الذين يفعلون الجور من تلقاءِ أَنفسهم، فإِنما يفعلون ذلك
إِما من قبل أَشياء هي في الحقيقة خيرات أَو يظن بها أَنها خيرات، وإِما
من قبل أَشياء هي في الحقيقة لذيذات، أَو من قبل أَشياء يظن بها أَنها
لذيذات. لأَن الذين يفعلون من تلقاءِ أَنفسهم إِنما يفعلون لمكان خير عاجل
أَو آجل. ولذلك قد يفعلون لمكان شر ينالهم، إِذا اعتقدوا أَنهم ينالون به
خيراً أَعظم من الخير الذي يفقدون بحدوث الشر، أَو اعتقدوا أَنه يندفع
عنهم بذلك شر عظيم أُو يكون اللاحق منه يسيراً. ولذلك قد نختار أَيضا
تعجيل المحزنات والمؤذيات، إِذا اعتقدنا أَننا ننال بها في الآجل خيراً
أَعظم أَو شراً أَقل من الشر العظيم الذي يتوقع حدوثه إِن لم نفعل ذلك
الشيءَ. ويستعمل هذا النحو من القصد في وجوه شتى. وإِذ قد تبين أَن الذي
يشتاقه الجائر فهو إِما نافع وإِما لذيذ، فقد ينبغي أَن ننظر هاهنا في
النافعات واللذيذات كم هي وأَي هي. لكن الأَشياء النافعة قد تقدم القول
فيها في باب المشورة. والذي بقي أَن نفرد القول فيه هاهنا هو القول في
اللذيذات. والقول فيها هاهنا وتوفية حدودها إِنما يكون بحسب الكافي في هذه
الصناعة وهي الحدود المشهورة وإِن لم تكن حقيقية، فنقول الآن:
إِن اللذة هو تغير إِلى هيئة تحدث بغتة عن إِحساس طبيعي للشيء
الذي أَحس، أَعني إِذا كان المحسوس طبيعيا للحاس. والحزن والأَذى ضد هذا،
أَعني أَنه تغير إِلى هيئة تحدث بغتة عن إِحساس غير طبيعي. وإِذا كانت
اللذة هذه صفتها، فهو بيّن أَن الذيذ هو المحسوسات التي تَفعلُ هذه الهيئة
في النفس. والمؤذيات ضد هذه، أَعني المفسدات لهذه التي تفعل ضد هذه الهيئة
في النفس الحسية. وإِذا كانت اللذيذات هي هذه، فمن الواجب أَن ما كان منها
بالطبع بهذه الصفة أَن يكون أَكثر لذة ولا سيما إِذا كانت هذه الهيئة
انفعالا لا فعلا. وإِنما صار الذي بالخلق والعادة لذيذا، لأَن الشيء الذي
يتخلق به أَو يعتاد يصير كالشيءِ الذي هو بالطبع لذيذ دائما من قبل أَن
العادة تشبه الطبيعة. وذلك أَن الذي يكون مراراً كثيرة قريب من الشيء
الطبيعي وهو الذي يكون دائما. والعادة تكون مراراً كثيرة، فهي قريبة من
الأَمر الطبيعي. والأَمر الطبيعي يكون بلا استكراه. ولذلك كان الإِكراه
مؤذيا محزنا، كما قال شاعر اليونانيين: إِن كل أَمر يكون باضطرار فهو مؤذٍ
محزن.
قال: والعناية بالشيءِ والجد والتعب مؤذيات، لأَنها تكون قسراً وبالكره
إِن لم يعتدها. فأَما أَضداد هذه فلذيذات، مثل الكسل والتواني ومخالفة
تقديرات الشرع للأَفعال والتودع والنوم من الأُمور اللذيذة، لأَنه ليس
شيءٌ من هذه باضطرار. وحيث كانت الشهوة، فهناك اللذة، لأَن الشهوة هي تشوق
إِلى اللذات. والشهوات منها نطقية، ومنها غير نطقية، وأَعني بغير النطقية
كل ما اشتهى لا من قبل الرويّة والفكر. وهذه هي التي يقال فيها إِنها
مشتهاة بالطبيعة كالشهوات المنسوبة إِلى الجسد مثل شهوة الغذاءِ المسماة
جوعا، وشهوة الماءِ المسماة عطشا، وأَنواع الشهوات المختصة بنوع نوع من
أَنواع الطعوم، وبالجملة: كل ما ينسب إِلى حس اللمس وحس الشم، مثل النكاح
والطعام والشراب والروائح الطيبة. فأَما شهوات السمع والبصر فإِنهما
يشتهيان مع نطق ما، أَعني أَنه ليس تنشأ شهواتهما معراة من النطق ابتداء،
كالحال في شهوة المطعوم والمنكوح. والسبب في ذلك أَن هاتين الحاستين أَكثر
مشاركة للنطق من غيرهما. وذلك أَن السمع يشارك النطق من جهة الأَلفاظ؛
ويشارك البصر النطق من جهة الخطوط والإِشارة المستعملة عند التخاطب.
والسمع أَشد مشاركة للنطق من البصر؛ وذلك ما يشتهى المرءُ كثيرا أَن يرى
ما سمع، وليس يشتهي أَن يسمع ما رأَى. لأَن الالتذاذ الحسي هو نوع من
الانفعال الجسماني أَكثر.
قال: فأَما التخيل فهو حس ضعيف، يفعل أَبداً إِما ذكراً، وإِما
تأَميلا. وإِذا هو عَدِمَ الذكر، عَدِمَ التأميل. وذلك أَن التأميل هو
ترتيب ممكن في المستقبل لأَشياء قد أَحست في الماضي وهو الذكر فمتى ارتفع
الذكر ارتفع التأميل ضرورة. وإِذا كان التخيل حسا ما، فبيّن أَن اللذة
إِنما توجد في الذكر والتأميل لأَنهما شيءٌ من الحس، حتى تكون اللذات كلها
إِنما توجد اضطرارا في الحس. وذلك أَنه إِذا كانت المحسوسات حاضرة
وبالفعل، كانت اللذة في مباشرتها وإِحساسها، وإِذا كانت فيما سلف، كانت
اللذة في ذكرها؛ وإِذا كانت فيما يستقبل، كانت اللذة في التأميل. وذلك أَن
الحس يختص بالأُمور الحاضرة، والذكر بالسالفة، والتأميل بالمستأنفة.
والمدركات اللذيذة ليست هي القريبة من الزمان الحاضر فقط، بل قد يكون بعض
الأَشياء كلما قرب عهده يوجد غير لذيذ، وإِذا بعد عهده وجد لذيذا. لأَن
القريب كالمملول، والبعيد العهد يصير عند الذاكر أَحسن وأفضل لبعد عهده به
فيشبه التأميل. وذكر المرء الكد والنصب الذي قد انقضى وتخلص منه لذيذ.
وذلك أَن الرجل الكدود الحريص يلتذ بذكر الكد والتعب، إِذا كان قد أَنجح
سعيه فيه أَو نجا به من الشر. فإِن النجاة من الشر أَيضا علة للذة. وأَما
الأَشياءُ الملذة التي تؤمل فهي التي إِذا كانت قريبة سرت أَو نفعت، وذلك
بأَن تظن جليلة أَو نافعة مع جلالتها إِذا كانت منفعتها ليس يلحق فيها
أَذى. وبالجملة فالمؤملات الذيذة هي القريبة من الزمان الحاضر السهلة
الوجود. ولذلك كان الغضب لذيذا، وذلك أَن الغضب إِنما يكون إِذا أَمل
الإِنسان إِيقاع الشر بالمغضوب عليه، وكان مع ذلك ممكن الوقوع. ولذلك قال
أُوميروش فيه: إِنه أَحلى من قطرات العسل. ولكون الغضب إِنما يكون إِذا
كان الانتقام ممكنا، لا حاضرا، ولا ممتنعا، ليس يغضب أَحد على الضعيف الذي
وقع الشر به، ولا على العظيم القدر الذي يُؤْيَس من وقوع الشر به وهو الذي
ليس لرتبته نسبة إِلى رتبة الغاضب عليه، مثل السُّوَق والملوك. وكذلك لا
يغضب على الصغير القدر جدا الذي ليس له إِليه نسبة. وكثير من الشهوات
تلزمها اللذة وهي حاضرة بالفعل، أَي محسوسة، بل وتلزمها اللذة وهي متخيلة،
ولذلك كان الذاكرون للشيءِ، المشتهى كيف ما يذكرونه، قد يجدون له لذة ما.
وكذلك الآملون أَن يظفروا بشيء قد يجدون بعض لذة ذلك الظفر. ولهذا كان
المحمومون الذين يمنعهم الأَطباءُ من شرب الماء يلتذون بتذكر شربه،
وبالرجاءِ أَن يبرأوا فيشربونه. والذين يَسئلون من الناس ما هو خير لهم
أَو يكتبون فيه أَو يسعون فيه فقد يلتذون بالطلب والسعي لأَنهم يرجون أَن
ينالوا تلك التي سأَلوا حتى تكون موجودة لهم فيلتذوا بإِحساسها بالفعل.
والأَشياءُ التي يحبها الكل محبة صادقة هي ثلاثة أَشياء: أَحدها أَن يكون
الشيءُ اللذيذ حاضرا، والثاني أَن يتخيلوه إِذا لم يكن حاضرا وذلك إِما
بتذكره وإِما بتأميله، والثالث سرعة السلو عن الغموم والأَحزان. ولذلك
يكرهون أَن يشاهدوا المغتمين ولا يحضرون المآتم والمناحات لأَنها تزيد في
الأَحزان. وبعض الشهوات يوجد فيها غم ولذة معا،. مثل تذكر المحبوب الغائب
أَو المائت إِذا فكر وذكر أَيّ امرئ كان وأَيّ أَفعال كانت أَفعاله. ولذلك
الذين يعملون المراثي تصيبهم لذة وغم معا.
قال: وقد أَجاد أُوميروش في هذا المعنى إِذ قال: إِنه لما تكلم الناعي
بالمرثية صرخ السامعون لها صرخة فاجعة لذيذة.
والأَخذ بالثأر يشبه أَن يكون يُعَد من هذا الباب، فإِن الأَخذ بالثأر يلذ
ويحزن معا، ويشبه أَن يعد من الأَشياءِ اللذيذة فقط. ومن الملذات أَلا
ينجح العدو. والذي يغضب إِذا لم يبلغ ما يؤمل من العقوبة يلتذ ويغتم معا.
أَما اغتمامه فمن قبل أَنه لم يبلغ ما يريده من العقوبة، وأَما التذاذه
فمن جهة تأميله البلوغ.
قال: والغلبة لذيذة ليس لمحبي الغلبة فقط بل المكل، لأَن الغلبة
هي شوق ما إِلى الشرف، أَعني أ، يكون له فضل ما معروف عند الناس، والشرف
يشتهيه الكل، وإِن كانوا يختلفون في ذلك بالأَقل والأَكثر. وإِذا كانت
الغلبة لذيذة، فإِن الآداب والرياضيات التي تكون لمكان الغلبة لذيذة
أَيضا، إِذ كانت نافعة في أَن يَنال بها اللذة، لأَن الغلبة بها تكون
أَكثر ذلك، وذلك كاللعب بالكرة والمثاقفة والشطرنج والنرد والحذق بجميع
الآداب المخرجة، أَعني الرياضيات التي يقصد بها تحصيل ملكة ما. وهذه
الآداب المخرجة على صنفين: منها ما ليس يكون لذيذا من ساعته حتى يعتاده
المرءُ فيكون لذيذا من قبل العادة، وهي الآداب التي ليس تلزمها اللذة التي
تلزم الملكة الحاصلة بأَخرة عن تلك عن تلك الآداب، بل إِنما يلزمها من
أَول الأَمر التعب فقط كالتأَدب بالحكمة؛ ومنها ما يكون لذيذا من ساعته
مثل التصيد واللعب بالشطرنج، فإِن المبتدئ فيها يشارك الحاذق فيها، أَعني
في الغاية التي يقصدها وهي الغلبة، فيلتذ بديا من أَول الأَمر، كما يلتذ
الكامل فيها. والغلبة بالعدل لذيذة. والغلبة التي تكون بالمشاغبة والتمويه
لذيذة عند السوفسطائيين الذين اعتادوا أَن ينالوا بذلك مقاصدهم وهممهم،
أَعني من الخيرات الخارجة، مثل اليسار والكرامة. ومن الأُمور اللذيذة
والجلالة، من قبل أَن الإِكرام يخيل للمكرم في نفسه أَنه فاضل أَو ممن
يجتهد في الفضيلة إِذا صدر الإِكرام ممن شأْنه أَن يوقع بإِكرامه للمكرم
مثل هذا الظن بنفسه والتخيل، أَعني أَن يتخيل أَنه فاضل. والحضور من
المكرمين أَحرى بهذا الفعل من الغيوب. إِذ كان الحضور يشاهدون من أَمره
مالا يشاهده الغيوب. فلذلك إِذا أَكرموا أَحداً، خيل للإِنسان المكرم
أَنهم أَكرموه من قبل فضيلة عرفوها فيه. وإِكرام العارف أَحرى بهذا من
إِكرام من ليس يعرف المكرم، لهذا المعنى بعينه. وأَهل مدينته أَحرى بذلك
من الأَباعد. والموجودون أَحرى بذلك من الذين يأتون من بعد، أَعني الذين
يكرمونه في حياته أَحرى بهذا المعنى من الذين يكرمونه بعد موته. وإِكرام
الأَكثر من الناس أَحرى بهذا المعنى من الأَقل. فإِن هولاءِ الأَصناف من
الناس أَحرى أَن يصدق قولهم في ذي العقل واللب من الناس وشهادتهم فيه أنفع
من الأَصناف الذين يتنزلون من الناس منزلة الأَطفال والبهائم وهم الجهال
والعوام. ولذلك ليس أَحد يعتد بتكرمة هؤلاءِ لأَحد ولا يحمد أَحد بذلك
إِلا يظن أَن ذلك منهم لمكان حسن الطاعة أَو الخوف منه.
والأَحباءُ أَيضا من اللذيذات، لأَن المحبة لذيذة. وكل من يحب شيئا فهو
يستلذه. ولذلك لا يستلذ الخمر أَحد لا يحبها. والسبب في ذلك أ، المحبوب هو
عند الحب من جملة الخير الذي يتشوقه الكل، وأَعني بالكل الذين يحسون
ويتخيلون. وأَن يكون الإِنسان محبوباً مقرباً من أَجل نفسه، لا من أَجل
آخر، لذيذ عند الإِنسان المحبوب، أَعني أَن يحب من أَجل نفسه. وكذلك أَن
يكون الإِنسان عجيبا عند غيره، أَي يتعجب منه الغير، لذيذ أَيضا من أَجل
هذه العلة، أَني من أَجل الخير الذي يتشوقه الكل. لأَنه إِنما يتعجب
منهإِذا انفرد بخيرٍ سبيلُه أَلا يكون في الأَكثر. وذلك أن الشيْ الذي
يفضل به على الأَكثر هو لذيذ. والذين يقصدون أَن يتعجب منهم هم أَمثال
القوم الذين يجمعون الناس ليروا ما يعملونه من تكلف الأَشياءِ العجيبة
والأُمور الفاضلة.
قال: والتملق أَيضا لذيذ، لأَن المتملق يخيل للإِنسان أَنه يتعجب منه،
وأَنه ممن يحبه. فالمتملق هو محب مُراء أَو مُعظم مُراء. وتكرير الشيء
الواحد بعينه يستلذ، لأَنه بتكرره يستولي على النفس. والمعتاد مستلذ.
والتبدل والتنقل من حال إِلى حال لذيذ بالطبع، لأَنه يستفيد به إِحساس شيء
جديد. ولذلك ما توجد الأَشياءُ التي تحدث في العالم بالطبع وقتا بعد وقت
لذيذة، مثل انتقال الفصول وتغير الدول. وبالجملة: التغييرات التي تحدث
بالناس وتغير الناس. والسبب في هذا أَن الشيء الحاضر هو في حد ما قد
استوفت النفوس منه حاجتها، ولم يبق لها فيه شيء تستفيده ولا سيما إِذا طال
وجوده، فتطلب النفس أَن تستريح إِلى شيء جديد تستفيد منه ما ليس عندها.
وكل ما كان الحادث كونه أَقل في الزمن، فهو أَلذ.
قال: والتعلم أَيضا لذيذ أَكثر ذلك. وشهوة التعلم في الجمهور
إِنما تكون من قبل شهوة الإِنسان لأَن يكون في نفسه عجيبا متعجبا منه، إِذ
كان هذان الأَمران لذيذين في أَنفسهما. وأَيضا فإِن التعلم لما كان من جنس
الإِدراك، الذي يصير بالطبع من القوة إِلى الفعل والكمال، كان أَيضا لذيذا.
وبالجملة فحسن الفعل وحسن الانفعال من الأُمور اللذيذة. وحسن الانفعال
إِنما يلتذ به، لا لنفسه، بل لمكان التشوق إِلى الكمال الحاصل، أَو الذي
يظن أَنه يحصل عنه. وأَما حسن الفعل فيلتذ به المرءُ لنفسه ولغيره وهو
الذي يقع به حسن الفعل.
وتأَديب القرابات لذيذ. والكفاية وسد الخلة لذيذ.
قال: وإِذا كان التعلم لذيذا، وكذلك يكون المرءُ عجيبا أَو متعجبا منه،
فإِن التخييل والمحاكاة أَيضا لشبههما بالتعلم لذيذة، وذلك مثل المحاكاة
بالتصوير والنقش وسائر الأَفعال التي يقصد بها محاكاة المثالات الأُول،
أَعني الأَشياءَ الموجودة لا الأَفعال التي تحاكي أَشياء غير موجودة. فإِن
التي تحاكي بها أُمورا موجودة ليس تكون اللذة بها بأَن تكون تلك الصور
المشبهة حسنة أَو قبيحة، بل ولأَن فيها ضربا من المقايسة. وتعريف الأَخفى
وهو الغائب الذي هو المشبه بالأَظهر وهو المثال الذي أُقيم مقامه ففيه
يضرب ما نوعٌ من أَنواع التعلم الذي يكون بالقياس. وذلك أَن خيال الشيء
يتنزل منه منزلة المقدمة، والشءُ الذي قصد تخييله وتفهيمه يتنزل منزلة
النتيجة. ولهذا الشبه الذي بين التخييل والتعلم كان التخييل لذيذا.
قال: والحيل والتخلص من المكاره لذيذ أَيضا؛ وإِنما صارت المحاكاة والتعلم
لذيذين، لأَن ذلك إِنما يكون بأَخذ الوصل التي بين الأَشياءِ. ومعرفة
الاتصالات التي بين الموجودات متشوقة للإِنسان بالطبع ولذلك كانت الأَشباه
والأَمثال لذيذة فإِن الإِنسان يلتذ بالإِنسان الشبيه به، والفرس بالفرس،
والغلام بالغلام. ومن هاهنا تنتزع الأَمثال، كما يقال: إِن الصبي يفرح
بالصبي، واللص يألف اللص، والطائر يقتنص بالطائر، والسبع لا يعدو على
السبع، وما أَشبه هذا. وبالجملة المتصلات والشبيهات كلها لذيذة في
أَنفسها. وما يجد كل واحد من اللذة في شبيه هو أَمر مشهور. وليس يلحق
المتشابهين تباغض إِلا بالعرض. واللذة إِنما هي في إِدراك الاتصال الذي
يكون بين شيئين من الأَشياءِ الموجودة في العالم. وكل واحد يحب نفسه، لكن
يفضل بعضهم في ذلك بعضا. فكل من وُجد له حب نفسه أَكثر، كان التذاذه
ومحبته للشبيه أَكثر. ومن أَجل أَن الإِنسان يحب نفسه، تكون حالاته لا
محالة لذيذة عنده، أَعني أَفعاله وأَقواله. ولذلك يوجد أَكثر الناس، وهم
الجمهور، إِنما يحبون الأَفعال الجميلة والكرامة والبنين لمحبة أَنفسهم.
وذلك أَن البنين أَثر من آثارهم. وسد الخلة لذيذ من هذه الجهة، لأَنه فعل
من أَفعاله وكذلك السلطان. وأَن يظن بالإِنسان أَنه حكيم هو لذيذ من أَجل
حب الإِنسان نفسه. وكذلك محبة الكرامة هي لذيذة من هذا المعنى. ونفع
الأَقارب من هذا المعنى هو لذيذ، والتسلط عليهم. وأَن يرتاض الإِنسان
بالأُمور التي ينال بها الفضيلة لذيذ وشريف، لأَنه يخيل له فيه أَنه قد
حاز تلك الفضائل التي ارتاض بها. ولذلك مدح أوميروش إِنسانا قسم نهاره
أَقساما يفعل في كل قسم منها فعلا يكتسب به نوعا من أَنواع الفضيلة. فإِنه
قد حاز تلك الفضائل لما قسم نهاره بتلك الأَقسام، وأَنه رجل فاضل على
التمام بها.
قال: والمضحكات لذيذة، والفكاهات المستطرفات لذيذة عند الناس لا محالة في
الأَفعال والأَقوال. وقد حددنا الأَشياءَ التي تعمل منها الطرائف والنوادر
في كتاب الشعر وكيف تعمل.
وإِذ قد تبين من هذا القول ما هي الأُمور اللذيذة، فقد تبين من ذلك ما هي
الأُمور المؤذية والمحزنة، فإِنها أَضداد تلك؛ وإِذا عرف أَحد الضدين عرف
الآخر.
ولإِذ قد تبين من هذا القول الأَشياءُ التي من أَجلها يجور الجائر وبها
يجور الجائر، فقد ينبغي أَن يصير إِلى القول في الكيفيات والأَحوال التي
تسهل الجور عليهم وتحركهم إِليه وأَية حالة هي الحالة التي يكون عنها
الجور، فنقول:
إنه قد يكون منهم الجور حين يظنون أَن ذلك الفعل مما يستطاع وهو
ممكن لهم، وأَن يكون مما يجهل ولا يعلم، أَو يكون مما ينسى في مدة يسيرة
إِن لم يكن مما يجهل. وإِن كان مما لا يجهل ولا ينسى فيكون مما لا يلحق
الجائر في فعله شر أَصلا لا له ولا لبعض من يعنى به لأَنه عنده مثل نفسه،
أَو يكون الشر اللاحق منه أَقل من المنفعة أَو اللذة التي ينالها بالجور
وذلك إِما للجائر أَو لمن يعنى به. فأَما ذكر الأَشياء التي بها يكون
الفعل ممكنا، فسيقال فيها بأَخرة وذلك في المقالة الثانية، لأَن القول في
ذلك عام في جميع المخاطبات الثلاثة. وأَما الأَحوال التي لا يللحق الجائر
بها شر أَصلا، أَو يلحقه دون الخير الذي يؤمله، أَو يكون الفعل مما يجهل
أَو ينسى في زمان يسير، فيقال ها هنا، إِذ كان ذلك خاصا بهذا الموضع.
قال: وقد يظن أَنهم قادرون على الجور أَكثر من غيرهم: الصنف من الناس
الذين يرون أَن لهم فضل قوة على غيرهم، وأَنهم يأْمنون من الشر اللاحق
لهم، إِذا جاروا، وذلك إِما في أَنفسهم، وإِما في من يعنون به، وهؤلاءِ هم
أَحد صنفين يفعل الجور بفضل قوة، وإِما صنف يفعله بتجربة وروية حتى يقدر
في نفسه النحو والجهة التي بها يسلم من الشر، وذلك بطول تجربته ومزاولته
المتقدمة. والجائرون يسلمون من الجور في عاقبة أَمرهم إِذا كانوا كثيري
الأَخوان، أَو كان أَخوانهم مياسير، ولا سيما إِن كان الإِخوان داخلين في
الأَمر معه، أَعني أَن ينالهم من الجور نفع أَو لذة، فإِنه تكون قدرته على
الجور أَكثر. وكذلك إِن كان الداخلون فيه المشاركون إِخوان الإِخوان أَو
خدم الإِخوان أَو أٌجراء الإِخوان أَو شركاؤهم أَو المنقطعون إِليهم، فإِن
الجائرين إِذا كانوا بهذه الصفة كانت لهم قدرة على الجور والامتناع من أَن
يعطوا طائلة أَو غرما. وقد يعرض لهم أَن تجهل أَفعالهم وتنسى، أَما جهلها
فمن قبل المشاركين لهم، وأَما نسيانها فمن قبل أَنه لا يبدأ بالتظلم من
االجائر أَولاً.
قال: ومما يسهل الجور أَن يكون الجائرون أَصدقاء للذين يجورون عليهم، أَو
يكونوا أَصدقاء للحكام. أَما كونهم أَصدقاء للذين يجورون عليهم فلأَمرين:
أَحدهما أَن الصديق لا يتحفظ من صديقه فيسهل الجور عليه. والثاني أَنه
إِذا جارعله أَرضاه بأَدنى شيء قبل الوصول إِلى الحكومة، لأَن اليق يتغابن
لصديقه. وأَما كون الحكام أَصدقاء فلأَن الحكام يقضون لمن أَحبوا بالميل
والهوى، وذلك إِما بأَن يعفوه من الغرم البتة، وإِما أَن يغرموه اليسير.
وهنا أَحوال أَضداد هذه الأَحوال المنسوبة إِلى القوة إِذا كانت في الجائر
كانت سببا إِلى وقوع الجور منه، وذلك كالمرض والضعف والفقر. فإِن الضعيف
والمريض قد يظن به أَنه لا يجور لأَنهم لا يحتملون العقوبة في أَبدانهم.
وأَما الفقير فلأَنه لي عنده ما يغرم. وفعل الجور إِذا كان في الغاية من
العلانية يخفيه ويوهم أَنه ليس بجور، وذلك أَن فعل الجائر، إِذا أَشبه فعل
المخاتل أَو الهازل، غالط، فظن به أَنه ليس بجور. وأَيضا فإِن أَحداً لا
يتحفظ من الجور الذي يكون علانية لقلة وقوعه، وإِنما يتحفظ من الجور
بالجهة التي أَعتيد أَن يكون منها وهو الإِخفاء. فإِن الجهة التي لم يعتد
منها فليس أَحد يحذرها. ولذلك لا يتحفظ منا ممن لا قدر له ولا من الإِخوان
والولد. ومن الناس من لا يتحفظ بأَفعاله فيوهم بذلك أَنه يجهل ما يفعل أَو
ما ينسى. وربما تغافلوا عن أَشياء تقع بهم حتى لا يتوهم عليهم أَنهم
يبتدئون بالجور أَصلا. ومما يعين الجائر القوة على الإِخفاء، وذلك إِما
بأَمكنة خفية تكون عنده وأَما بحالات فيه من شأْنها أَن تخفى أَفعاله، مثل
أَن يكون ظاهره ظاهر من لا يظن به الفعل القبيح. وقد يتمكن من الجور الذين
لا يجهلون ولا يجهل جورهم إِذا كان الحكام يجورون بأَحد معنيين: إِما بأَن
يحرفوا السنة، وإِما بأَن يسوفوا الحق حتى يمل صاحبه ويترك طلبه. ولذلك
اذا كان الجائر له قدرة على التراوغ عن الغرم أَو المماطلة أَو كان عديما
سهل عليه الجور.
والذين تكون لهم المنافع التي يستفيدونها من الجور ظاهرة بينة
أَو عظيمة أَو قريبة حاضرة، والمضار اللاحقة عنه إِما قليلة وإِما مجهولة
وإِما بعيدة في الزمان بطيئة، يسهل عليهم الجور، وذلك أَنهم لا يتركون
النافع المتيقن به للضار المجهول وقوعه، وكذلك لا يتركون النافع العاجل
لمكروه آجل، ولا المنافع الكثيرة لمكروه يسير. ومما يسهل الجور أَن يكون
فعلا يمدح به الجائر ويذكر، مثل ما يعرض للذي يأْخذ ثأْره في الجائر عليه
أَو في أَبيه وأمه. والذي يكون له ثأْر عند واحد من أَهل مدينة فيقتل أَهل
المدينة بأَسرها، وبخاصة إِذا كان الضرر اللاحق لهم في المال والاغتراب
فإِن هذا كثيرا ما يمدح به، كما قال الشاعر:
عليكم بداري فاهدموها فإِنها ... تراث كريم لا يخاف العواقبا
وهؤلاءِ يظلمون في الأَمر والمنع، أَعني أَخذ ما ليس لهم ومنع ما عليهم.
فهذه هي الأَشياءُ التي تسهل على أَهل الهمم والروية والجور. فأَما أَضداد
هؤلاءِ في الأَخلاق والرأي وهم الضعفاءُ الرأي والخلق فقد يحركهم إِلى
الجور توقع نفع يسير مجهول، أَعني غير متيقن أَن ينال أَو لا ينال، وقد
يحركهم إِلى الجور خوف خسران يسير يدخل عليهم لا أَن يستفيدوا بجورهم شيئا
يدخل عليهم سوى أَلا يخسروا شيئا يسيرا من كثير ما معهم وقد يحرك هذا
الصنف من الناس إِلى الجور أَن يجوروا فيخطئوا غرضهم ولا يظفروا بما راموا
من الجور فيحركهم ذلك على أَن يجوروا مرة بعد مرة، كما يعتري كثيرا من
المنهزمين أَن يعودوا إِلى القتال على جهة اللجاج بعد أَن يهزم مرة ثانية.
والذين تحركهم إِلى الجور اللذة في أَول الأَمر مع الحزن الذي يكون بأَخرة
أَو يستعجلون المنفعة أَولا مع وقوع المضرة بهم في العاقبة، وأُخر هم
أَيضا من هذا الصنف. فإِن الضعفاء الرأي قد يوجدون بهذه الحال عند كل ما
يشتاقون إِليه. وأَضداد هؤلاءِ هم الذين يحركهم إِلى الجور أَن يكون
المؤذي الضار متقدما لهم، واللذيذ النافع متأَخرا أَو بعد زمان. وهؤلاءِ
فهم ذوو الأَصالة واللب الذين في الغاية، وهم أَهل الشر العظيم لأَنه يظن
إِن تلك المنافع واللذات المتأَخرة لم ينالوها بجورهم، وإِنما نالوه بوقوع
الجور منهم والضرر الذي يتعجلونه أَو الأَذى، فلا يظن بهم الجور أَصلا.
وقد يحرك ذوي الدهاءِ والمكر إِلى الجور أَن يخرجوه في صفة ما لا يظن به
أَنه جور. وذلك يكون بوجوه: أَحدها أَن يظن أَن ذلك الفعل كان باتفاق، أَو
يظن أَنه كان بإِكراه، أَو يظن أَنه كان من أَجل طبيعة، أَو أَنه كان عن
خطأ وجهل لا عن تعمد، أَو أَنه كان عن عادة تقدمت له، أَو يكون الفعل بحيث
لا يستفيد منه شيئا ينتفع به في الحاضر بل في المستقبل. فإِن الذي لا
يستفاد منه شيءٌ في الحاضر يظن به أَنه غير مقصود لأَحد وأَنه غير محتاج
إِليه وأَنه لا يجار إِلا من قبل ما يحتاج إِليه. والمحتاجون على ضربين:
إِما بالضرورة كالفقراءِ، أَو بالشره كالأَغنياءِ. والجور على جهة الضرورة
أَعذر على جهة الشره، ولذلك يهون هؤلاءِ جدا، وإِن كانوا كثيرا ما ينجحون.
وذو اللب والحزم إِذا ظفر بالشيءِ الذي جار من قبله يُرى كأَنه لا يستحسن
ذلك الشيءَ ولا يسر به. وأَما ذوو الرأْي الضعيف فهم يظهرون السرور بما
ينالونه بالجور. والجائرون من قبل واحد من هذه الأَسباب المخفية للجور
والمسهلة له، إِذا ظفروا بما أَملوه من ذلك، فقد صدقت ظنونهم.
فهذا جملة ما قاله في الأَشياءِ التي تسهل الجور على الجائرين وتبعثهم
عليه.
وأَما الذين يضر بهم الجائرون وهم المظلومون بالطبع، أَعني الذين
يطمع فيهم أَهل الشر، فهم الذين يجهلون ما يفعل بهم فلا يرون أَنه جورٌ،
أَو الذين ينسون ما يفعل بهم من الجور بسرعة، وإِن لم يجهلوه، وما أَشبه
هؤلاءِ من الذين لا إِخوان لهم أَو لهم إِخوان فقراء. والجور الذي يكون في
المال إِنما بمن يقع بمن عنده مال، إِذا كان في ذلك المال الشيءُ الذي
يحتاج إِليه الجائر، وذلك إِما لموضع الضرورة إِن كان فقيرا أَو لموضع
الشره إِن كان غنيا قصده جمع المال فقط أَو لموضع التنعيم إِن كان قصده
إِنفاق المال والتمتع به. والمسوفون بطلب حقوقهم يقع بهم الجور كثيرا،
وكذلك القرابة والإِخوان، وذلك أَن المرءَ لا يتحفظ من صديقه. وإِذا جار
عليه فقد يجهل أَنه جار عليه. فجميع هؤلاءِ الأَصناف يمنعهم من الانتقام
من الجائر إِما عدم الناصر كالفقر وعدم الإِخوان، وإِما تسويف الانتقام
وتأْخيره. ولذلك كثيرا ما ينجح الذين يسلبون أَقرباءَهم حين يجهلون جورهم
من أَول الأَمر حتى يدرس وينسى.
والصنف من الناس المتوَقَّين من الشر المتباعدين منه الذين يصونون أَنفسهم
عن أَن يبتذلوها في الخصومات كثيرا ما يجار عليهم.
وكذلك يعرض للناس الذين لا يتحفظ من شرهم الصحيحي المعاملة الموثوق بهم المنصفين، أَعني أَن يطمع في الجور عليهم. وهؤلاءِ قد يمكن أَن تجهل منهم هذه الأَحوال فلا يتصدى أَحد للجور عليهم. وذوو الكسل والتواني يطمع في الجور عليهم. وكذلك الجاهلون بما هو جور وعدل، وبالجملة: بما يحكم به الحاكم، لأَن استخراج الحقوق عند الحكام إِنما هو للرجل البصير النافذ، أَعني العارف بما يحكم به الحكام. ومن الذين يجار عليهم الصنف من الناس الذين يغلب عليهم الحياءُ، لأَنه ليس عندهم صخب ولا مغالطة في طلب منافعهم. والذين أَيضا قد ظلمهم ناس كثيرون يجار عليهم لأَنهم يلفون قد ذلت نفوسهم وأَمن شرهم. والذين ليس تخرج لهم الأَحكام إِذا حضروا مجالس الحكام والسلاطين، إِذ ليس لهم قدر، يجار عليهم. لأَن هؤلاءِ كما قيل منحون أَبداً. والذين أَيضا يرومون الأَخذ مرارا كثيرة فلا يأْخذون شيئا يجار عليهم. لأَن كلا الصنفين مزدرى به لا يتحفظ منه إِلا على الإِطلاق وإِما في وقت ما. لأَن هؤلاءِ القوم مذمومون، والمذمومون لا يتحفظ منهم، لأَنه لا ناصر لهم. وإِنما كان ذلك كذلك، لأَن هؤلاءِ لا ينفذون إِراداتهم ولا آراءهم، لأَنهم يخافون الكلام ولا يستطيعون أَن يأْذنوا أَو يمنعوا. وذلك أَنه لا يخلوا واحد من هؤلاءِ أَن يكون متقدما عليه في المجلس أَو مستهانا به أَو منفورا عنه. والذين عندهم لقوم ترة قديمة أَو سوءُ بلاء إِما من قبل أَجدادهم أَو من قبل آبائهم أَو من قبل أَنفسهم أَو من قبل إِخوانهم مهيئون أَن يجور عليهم أُولئك القوم جورا أَكثر من الجور المتقدم. وكذلك إِن كانوا تهاونوا بهم أَو بآبائهم أَو بمن يعنون به. ولذلك يقال في المثل: إِن الشر اليسير يستثير الكثير، وإِن الشر قد تبديه صغاره. والذين تقدمت منهم ترة قديمة: إِن كانوا أَصدقاء وتقدمت منهم ترة يسيرة، فإِن القول فيهم واستماعه يكون سهلا، لا يقع من المقول فيه موقع مكروه. وإِن كانت الترة كبيرة، كان القول فيهم أَو استماعه لذيذا عند الذين لهم الترة عندهم. وإِن كانوا أَعداء، كان القول فيهم واستماعه مع تهاون بهم وأَلا يرى لهم قدر. فالمستمعون إِما أَلا يقولوا فيه شيئا، وإِما أَن ينكروا على القائلين، وإِما أَن يمالئوا على القول ويزيدوا فيه. وهنا صنف من الناس يجار عليهم وينالون بالضر والانتقام، لا لمنفعة، لكن لمكان الاستلذاذ بذلك. وهؤلاءِ هم الغرباءُ: إِما في المدينة، وإِما في الجنس، وإِما في الشيم، وإِما في اللسان، وإِما في المللة. فإِن الإِنسان يستلذ الجور على الغرباءِ بأَحد هذه الخمسة الأَنحاء. والجور الواقع بهؤلاءِ هو التهاون. فإِن الجور يكون في المال والكرامة والسلامة. وأَهل الغفلة يجار عليهم أَيضا. وإِنما يستلذ الجور على الغرباءِ لأَنهم لا يعرفون ما هو إِهانة واستخفاف عند أَهل تلك المدينة، أَو عند ذلك الجنس وكذلك الحال في أَهل تلك الغفلة. ومن الذين يستلذ الجور عليهم الصنف من الناس الذين يقلقون بالأَشياءِ اليسيرة ويصيبهم منها كرب، وذلك بيّن في أَفعال أَهل اللعب في هذا الصنف من الناس.
قال: والذين جاروا كثيرا على الناس قد يستلذ الجور عليهم لا
لمنفعة، ويظن به أَنه قريب من أَلا يكون الجور عليهم جوراً، وذلك مثل أَن
يضرب أَحدٌ من قد تعود شتيمة الناس ونقصهم، فيشجه أَو يجرحه. والذين أَيضا
أَتوا أَمرا قبيحا فاحشا عند الناس إِما بعمد وإِما بغير عمد، فإِن الجور
عليهم لذيذ حسن عند الناس، والفاعل لذلك يرى غير جائر. والذين يسرون أَيضا
بأَفعال هؤلاءِ أَو هم أَصدقاؤهم ويتعجبون من أَفعالهم.وبالجملة من أَتى
سوءاً يستلذ الناس الجور عليهم، وكذلك بالجملة الذين يتعلقون بمن فعل
سوءاً أَو يمشون معه. والصابرون من الناس المغضون بالحقيقة يستلذ الناس
الجور على من جار عليهم. والذين يبتدئون بالظلم، فإِن الظلم الواقع بهم
قريب من أَلا يكون جوراً، ولذلك قيل: البادئ أَظلم، وذلك مثل أَن يقتل
إِنسان من قصده بالقتل. والقوم الذين يصادفون على شرف من الهلاك قد يبادر
الناس للجور عليهم، لأَنه يخفى أَنهم كانوا سبب ذلك الجور. وقد يستلذ
الجور على الطائفة التي تجور على من أَشرف على الهلاك، وبخاصة إِذا كانوا
أَقوياء على دفعهم فتظالموا لهم وتعافوهم وأَبوا أَن يؤذوهم. ويعلم مع هذا
أَنهم لو لم يصيروا إِلى هذه الحال بتظالمهم وتعافيهم عن الطائفة التي
أَصارتهم إِلى هذه الحالة من الإِشراف على الهلاك لما تجرأَت الطائفة
الأَخيرة أَن تجور عليهم، كما عرض، فيما حكاه، في جزيرة معلومة عندهم،
وذلك أَن قوما سبوهم غصبا وجورا لأَنهم صادفوهم على شرف من الهلاك من قوم
آخرين، وقد كانوا يقدرون أَن يدفعوا عن أَنفسهم ظلم الذين صيروهم بهذه
الحال فلم يفعلوا ولكن تظالموا لهم وعفوا عنهم حتى صاروا من أَجل ذلك إِلى
حالة أَمكن فيها هؤلاءِ الآخرين أَن يسبوهم جورا وغصبا.
فهذه هي الأَشياءُ التي إِذا كانت في الإِنسان حركت الجائر إِلى الجور
عليه، وهم المظلومون بالطبع. وأَما الأَشياءُ التي يسهل الجور فيها فيجور
فيها الكل والأَكثر من الناس فهي الأَشياءُ التي يكون فيها الصفح هي
الأُمور اليسيرة الحقيرة. والأَشياءُ التي تستتر فتخفى هي الأَشياءُ التي
تفسد أَعيانها سريعا مثل الطعام، أَو الأَشياءُ التي يسهل تغير أَشكالها
أَو أَلوانها أَو التي تغير بالمزاج والخلط.
والأَشياءُ بالجملة التي يمكن أَن تغير أَشكالها في أَمكنة كثيرة منها هي
أَسهل إِخفاء ولا سيما إِذا كان التغيير منها في أَمكنة صغار. فإِنه كلما
كان إِمكان التغيير في الشيءِ أَكثر وأَسهل كان إِخفاؤه أَسهل. وكذلك تخفى
الأُمور التي يعلم أَنه قد كان عند الجائر أَشباهها أَو ما لا يشبهها
فيدخلها في جملة ما يشبهها أَو يغيرها إِلى التي لا تشبهها من التي تعلم
أَنها عنده. ولذلك يتقدم كثير ممن يريد أَن يظلم فيقتني نوع الشيءِ الذي
فيه يريد أَن يظلم أَو نوع الشيء الذي يريد أَن يغيره إِليه. وكل ما يستحي
المظلوم من ذكره فهو مما يخفى مثل الجور في النساءِ، فإِن إِظهاره فضيحة
وعار على المجور عليهم في أَولادهم.
فهذه الأَشياءُ وما أَشبهها هي الأَشياءُ التي يسهل فيها الجور، إِذ يكون
فيها الصفح أَو الاستتار. فقد تبين من هذا القول الأَشياءُ التي من أَجلها
يجور الجائر، والأَحوال التي إِذا كانت في الإِنسان طمع أَهل الجور فيه.
وبقي الصنف الثالث من الأَشياءِ الثلاثة التي منها تؤخذ المقدمات التي
يتبين بها أَن الجائر قد جار، وهي معرفة الأَفعال التي إِذا تبين أَنهم
فعلوها، فقد تبين أَنهم قد جاروا، والأَحوال التي إِذا كانت في الفعل كان
جورا. وينبغي أَن نقدم أَولا أَصناف الظلم وأَصناف الواجب، أَعني ما ليس
بظلم. وقد قيل فيما سلف أَن أَصناف الظلم تكون نحو شيئين وهما إِما
اللذيذ، وإِما النافع، وإِنها توجد في الذين توجد فيهم على جهتين: إِما
لدفع مضرة، وإِما لاجتلاب منفعة.
والسنن التي توقف على ما هو جور وعلى ما ليس بجور منها خاصة
بطائفة من أَهل المدينة، ومنها ما يعم جميع أَهل المدينة. وهذان الصنفان
من السنن مكتوبة، ومنها غير مكتوبة، وأَعني بغير المكتوبة تلك التي هي في
طبيعة الجميع وهي التي يرى الكل فيها بطبعه أَنها عدل أَو جور، وإِن لم
يكن بين واحدٍ واحدٍ منهم في ذلك اتفاق ولا تعاهد. وهذه أَيضا قد تسمى
عامة بهذه الجهة. وهذه السنن ليس يعلم متى وضعت ولا من وضعها. وهي كثيراً
ما تضاد المكتوبة. فيقنع بها، فيما اعتقد فيه أَنه جور بحسب المكتوبة،
أَنه ليس بجور. كما حكى أَرسطو عن رجل مشهور عندهم لما أخبر عنه بأَنه دفن
على غير سنة الدفن الخاصة ببلده، اعتذر عنه في ذلك بأَنه دفن على السنة
العامة الموجودة في الطبيعة، وإِن دفنه كان عدلا لا جورا. وأَما السنن
المكتوبة الخاصة بقوم قوم فهي مثل ما يرى بعض الناس أَنه لا ينبغي أَن
تقتل ذوات النفوس كالحيوانات وأَنه جور. فإِن هذا ليس واجبا عند الجميع
ولا بالطبع. وإِذا كانت السنن الموقفة على العدل وما ليس بعدل: منها ما هي
نحو العامة والكل من أَجل المدينة، ومنها ما هي نحو واحد واحد، أَعني أَن
منها سننا توقف على ما ينبغي أَن يفعل في أَمر العامة وأَلا يفعل، وسننا
توقف على هذا المعنى في أَمر واحد واحد، فبيّن أَن أَصناف الظلم والواجب،
أَعني ما ليس بظلم، تنحصر في هذين الصنفين، أَعني أَن الظلم وفعل الواجب:
إِما أَن يكون نحو واحد واحد، وإِما أَن يكون نحو الجميع. مثال ذلك أَن
الذي يزني أَو يضرب هو ظلم نحو واحد محدود، والذي يمتنع من الدخول في
الشرطة، وهي عند أَرسطو حراسة أَهل المدينة بعضهم من بعض، فقد يظلم ظلما
عاما. وكذلك الذي يمتنع من الحراسة، وهو الذي يحفظ المدينة مما يرد عليها
من خارج ولا يتعدى في حفظه حدود المدينة، أَو الذي يمتنع من القيادة وهو
الذي يسير بجند المدينة وحماتهم إِلى قوم غرباء للغلبة على نفوسهم أَو على
أَموالهم أَو على مدينتهم. وكل واحد من هؤلاءِ متى لم يفعل فعله، لحق
المدينة منه جور عام وضرر شامل. فهذه القسمة واقعة في جميع أَصناف الظلم،
أَعني أَن منه ما هو عام، ومنه ما هو نحو واحد واحد.
وإِذ قد وصفنا أَصناف الظلم، فقد ينبغي أَن نصف ما هي الظلامة، أَعني
المعنى الذي إِذا وقع بالإِنسان وانفعل له سمى مظلوما، فنقول: إِن الظلامة
هي أَن يمس إِنسانا شيء من الجور من إِنسان آخر بمشيئته واختياره. وذلك
أَن الجور، كما قد قيل، إِنما هو إِضرار يكون بالمشيئة. فالظلامة هي أَن
يستضر آخر بمشيئة الجائر.
وأَصناف الأَشياء الضارة إِحصاؤها في هذا الموضع واجب، إِلا أَنه قد ذكرت
فيما تقدم، وذلك في باب المشورة، لأَنه لما ذكرت النافعات هنالك تبينت
أَضدادها؛ وكذلك هي أَيضا مذكورة في باب الذم. وكذلك قد تقدم القول في
أَصناف الأَشياء التي تكون عن طوع. والشكايات - بالجملة - العامة والخاصة
تنحصر في أَربعة أَصناف: أَحدها ما يكون بلا علم من الفاعل وهو الكائن عن
الاتفاق؛ والثاني ما يكون مع علم بلا مشيئة وهو الإِكراه؛ والثالث ما يكون
عن اختيار وروية؛ والرابع ما يكون عن انفعال من الانفعالات، وأَكثر ما
يكون ذلك عن الغضب. فأَما الغضب وما يكون عنه فسيقال فيما بعد. وأَما التي
تكون عن تقدم الاختيار والروية فقد قيل فيها فيما تقدم. وليس يحتاج الشاكي
إِلى معرفة أَصناف الظلامات والأَفعال التي هي جور أَو إِلى معرفة الشرائط
التي يكون بها الفعل ظلما وجوراً بل وقد يحتاج إِليه المتنصل والمعتذر،
لأَنه كثيرا ما يعترف المشتكي به بوجود الذي ادعى عليه، إِلا أَنه يجحد
الشرط الذي به يكون ذلك الفعل جوراً؛ وذلك مثل أَن يعترف بأَنه أَخذ، لا
بأَنه سرق؛ وبأَنه سب، لا بأَنه افترى؛ وبأَنه نكح، لا بأَنه زنى. ولذلك
ينبغي للشاكي والمتنصل أَن يعرف ما السرقة وما الافتراءُ وما الزنا وذلك
بحسب الشريعة العامة والخاصة بالقوم الذي هو منهم؛ فإِنه بمعرفة هذه
الأَشياء يمكن الشاكي أَن يثبت أَن الفعل جور وظلم، والمتنصل أَنه ليس
بجور. فإِن التنازع إِنما هو في أَنه ظالم أَو غير ظالم. والظلم بالحقيقة
الذي لا يقبل المعذرة إِنما هو الظلم الذي يكون عن تقدم الروّية والاختيار.
وهاهنا ظلامات أَسماؤها الدالة عليها كافية في الدلالة على أَنها
ظلم في الغاية وعلى تقدم الاختيار والروية لها دون أَن يحتاج في ذلك إِلى
تحديدها، مثل السرقة والزنا. فإِن أَحداً ليس يتصور فيه أَنه يسرق أَو
يزني غير مختار. ولذلك إِذا اعترف بهذه الأَسماءِ المدعى عليه، لم يبق له
موضع اعتذار. فيجب على المتنصل أَبدا أَن يتحفظ من الاعتراف بهذه
الأَسماءِ. وإِن اعترف فلا يعترف منها إِلا بالجنس فقط، مثل أَن يعترف
بأَنه سب لا بأَنه افترى، ويقول: لأَن الافتراءَ إِنما هو قذف الرجل أَو
قذف أَبويه بالزنا. وذلك أَن الذم بالنقائص يتفاضل. فإِن هاهنا نقائص لا
يلحق الإِنسان منها بها عار وإِن كانت تضع منه، مثل البخل. وهاهنا نقائص
تضع من الإِنسان ويلحقه منها عار عظيم، مثل الزنا. ولذلك غلظت الفرية في
شرعنا. وكذلك يقول: إِنه أَخذ، لا أَنه سرق، إِذ كانت السرقة إِنما هي من
حرز.
فصل
قال: وبعض الظلامات وما ليس بظلامات فيه سنن، وبعضها ليس فيها سنن. وما فيها سنن: فمنها ما هي سنن مكتوبة، ومنها ما هي غير مكتوبة. وكل واحدة من هذه ترسم العدل والجور، والخير والشر. فالخير بحسب السنن الغير المكتوبة هي الأَفعال التي كلما تزيّد الإِنسان منها إِلى غير نهاية تزيد حمده ومدحه أَو كرامته ورفعته، مثل معونة الأَصدقاءِ ومكافأَة المحسنين. والشر بحسب السنن الغير المكتوبة هو الفعل الذي كلما تزيد الإِنسان منه لحقته المذمة أَزيد، والهوان أَزيد، وذلك أَيضا إِلى غير نهاية، مثل كفر الإِحسان والإِساءة إِلى الأَصدقاءِ. وأَما الخير والشر في السنن المكتوبة فإِنه مقدر لا يزاد فيه ولا ينقص منه. ولما كان الأَمر على هذا وكانت السنة المقدرة لا تنطبق على كل شخص ولا في كل وقت ولا عند كل مكان، لم تكن كافية فيما تقدر من الخير والشر في معاملة شخص شخص من أَشخاص الناس، فاحتيج إِلى الزيادة والنقصان فيها بحسب ما تقتضيه السنة الغير المكتوبة. فوجب أَن يكون في هذه السنن الغير المكتوبة عدل مكتوب وتفضل: وهو إِما الزيادة على السنن المكتوبة، وإِما النقصان منها. فإِن كانت الزيادة على الخير المكتوب سمي إِحسانا، وإِن كانت الزيادة على الشر المكتوب سمي حِسبة. وإِن كانت نقصاناً من الشر المكتوب سمي صلحا وحلما واحتمالا، وما أَشبه ذلك من الأَسماءِ. وهذا قد يعرض في السنن المكتوبة للواضعين: إِما باضطرار، وإِما من قبل أَنفسهم. أَما من قبل أَنفسهم: فإِذا هم غلطوا فوضعوا تحديدا كليا، وليس بكلى. وأَما من قبل الأَمر نفسه: فمن قبل أَنه ليس يستطيع أَحد أَن يضع سننا كلية عامة بحسب جميع الناس في جميع الأَزمنة وجميع الأَمكنة، لأَن ذلك غير متناه، أَعني تبدل النافع والضار. وغاية الماهر في وضع السنن أَن يضع من ذلك ما هو أَكثري، أَعني لأَكثر الناس في أَكثر الأَزمنة وأَكثر المواضع. وكلما اجتهد الواضع في أَن تكون السنة التي يضعها منفعتها أَطول زمانا وللأَكثر من الناس، كانت السنة أَفضل. وإِذا كان الأَمر كذلك، فباضطرار أَلا تكون السنن المقدرة صادقة أَبدا ودائما، أَعني في كل شخص وفي كل وقت، ولذلك قد يحتاج إِلى الزيادة والنقصان فيها. وأَنت تتبين هذا من الملل المكتوبة في زماننا هذا.والزيادة والنقصان فيها إِنما تكون تفضلا إِذا لحق ذلك مدح أَو كرامة. والحلم بالجملة هو التفضل في نقصان الشيء المكتوب أَو رفعه في الموضع الذي يلحق ذلك مدح أَو كرامة. مثال ذلك ما حكاه أَرسطو من أَن السنة كانت عندهم أَلا يشيل أَحد يده بالخاتم وأَن فعل ذلك يستوجب عقوبة وأَنه ظالم. والسنة الغير المكتوبة تقتضي أَن يصفح عن مثل هذا. فالصفح إِذن عن مثل هذا عدل. وكذلك يشبه أَن يكون الأَمر عندنا في قطع اليد في النصاب وبخاصة في المطعومات. وإِذا كان هذا هو الحلم فهو بيّن أَي الأَشياء هي من الحلم وأَيّ الأَشياء ليست هي من الحلم وأَيّ الناس هم الحلماءُ وأَيهم ليس كذلك. فإِن المرءَ إِنما يكون حليما في الأَشياءِ التي يجمل فيها الصفح.
قال: وضروب الإِساءة والظلم وإِن لم تكن صنفا واحداً بل أَصنافاً كثيرة، فليس يجب أَن يسوى بين ما يقع منها على جهة الخطاءِ وهو الذي يكون من السهو والغلط، وما ليس يقع على جهة الغلط وهو الذي يكون عن المكر والشر.
قال: والإِساءة: هي ما لم تكن عن جهل ولا عن شرارة؛ وأَما الظلم
فهو ما كان من شرارة، لا من جهل.
والمقدمات التي بها يخاطِب من يَسئل الصفح عن الذنب الذي أَوجبت العقوبةَ
فيه الشريعةُ المكتوبة على فاعله، أَعني التي ذكرها أَرسطو في هذا الكتاب:
إِحداها أَن يقول الجاني: إِنه، أَيها المعاقب، يجب أَلا تقتدي بهذه السنة
نفسها في ما أَوجبته علىّ من العقوبة، لكن بخلق الواضع لها في الصفح
والرحمة.
والمقدمة الثانية أَن يقول: إِنه ليس يجب أَن ننظر إِلى ظاهر لفظ الشارع
في هذه العقوبة التي وضعها، لكن إِلى مقصوده، وذلك في الموضع الذي يكون
المفهوم من اللفظ ضد ما يقتضي ظاهره من العقوبة. والثالثة أَن يقول إِنه
ليس يجب أَن نتنزل العقوبة على حسب الفعل الظاهر مني، لكن على حسب النية
والاختيار، وذلك حيث يظن أَن ذلك الفعل لم يكن عن اختيار منه. والرابعة
أَن يقول: إِنه ليس ينبغي أَن يعاقب على ما كان في الفرط ونادرا، لكن على
ما كان متكررا من الجاني، وذلك إِذا لم يتقدم منه ذلك الفعل. والخامسة أَن
يقول: إِن الإِنسان ليس ينبغي أَن يعاقب على حسب حاله الحاضرة حتى ينظر
إِلى أَحواله المتقدمة وأَحواله المستقبلة، وذلك عندما تكون هذه الأَحوال
شافعة له. والسادسة أَن يذكره بالخيرات التي وصلت من الجاني إِلى المجني
عليه. والسابعة أَن يذكره بالخيرات التي وصلت إِلى الجاني من المجني عليه،
فإِن ذلك يحركه إِلى أَن يعدو العفو عنه من جملة تلك الخيرات. والثامنة
أَن يحرضه على التأَني عند الظلم بأَن يقول له: إِنه ليس ينبغي أَن يعجل
الإِنسان إِذا ناله جور من إِنسان، فيكافئه بالعجلة، لكن يتوقف، فعسى أَن
يكون في عاقبة ذلك خير يناله. والتاسعة أَن يقول: إِنه ينبغي للإِنسان أَن
يكون مع الناس مسامحا يقنع بالقول الجميل دون الفعل، وأَلا يكون شديد
الاستقصاءِ. والعاشرة أَن يقول: إِنه ينبغي لللإِنسان أَن يكون متنزها عن
الخصومات والعقوبات. والحادية عشرة أَن يقول: إِن الاحتمال والصفح من
الخلق الفاضل؛ والمتهورون وذوو الخَرَق يقرون بهذا إِذ يتشبهون بالحلماءِ
فضلا عن غيرهم.
فقد تبين من هذا القول: ماهو التفضل والحلم والصفح، وما الحالم والصافح،
ومن أَي من المتقدمات يستدعى الحلم والصفح. ولأَن المجني عليه يعظم الظلم
الواقع به والجاني يصغره، فقد ينبغي هاهنا أَن يقال في أَنواع الظلم
العظيم والظلم اليسير.
ومن الظلم العظيم ما يكون من الإِنسان القوي للضعيف، وما يكون من الغني
للفقير. ولذلك ما قد يكون الظلم في الأُمور اليسيرة عظيما: إِما من عظم
الشر نفسه الموجود في ذلك الشر اليسير، وإِما من عظم الضرر. أَما عظم
الضرر في الشيءِ فمثل من يسلب الإِنسان قوته إِذا كان يسيرا وليس ملك
غيره. وأَما الشر الذي هو عظم في نفسه، وإِن كان الفعل يسيرا، فمثل ما حكي
أرسطو أَن رجلا خان الصناع الذين كانوا يدعون عندهم بالمقربن، وهم
المختصون عندهم بصناعة محاريب البيوت المختصة بعبادة الله في ثلاثة أَفلس
من مقدسة من المال المختص ببيوت العبادة.
قال: فإِن ثلاثة أَفلس هي شيء يسير من طريق الجور في المال،
وأَخذها من طريق ما هي من المال المقدس للصناع المقربين شر عظيم، وذلك أَن
لك يدل على قوة الشر الذي في أَخها إِذ كان قد هتك حرمة بيت الله وحرمة
ماله، ولذلك فاعل هذا ليس يرى أَحدٌ أَنه اتقى من الظلم شيئا، بل بلغ فيه
الغاية. وأَما إِذا اعتبر مقدار المضرة في أَخذ الأَفلس الثلاثة، فليس
هنالك ظلم يعتد به. وأَمثال هذه المظالم، أَعني التي تقع ببيوت الله
وأَوليائه، ليس فيها صفح ولا حلم ولا احتمال، لأَن الصفح فيها والحلم ليس
تقتضيه مصلحة، بل يجب أَن يكون الحاكم في أَمثال هذه ينفذ العقوبة ولا بد،
إِما لمكان الانتقام من الجاني فقط، وإِما لما في ذلك من المصلحة العامة
ولمكان هذا، قال الفقهاءُ عندنا إِن من قال في صاحب الشريعة عليه السلام
إِن زره وسخ قتل. ومن الظلم العظيم أَن يجمع على الإِنسان أَخذ ماله
وتعذيبه. ومن الظلم العظيم أَيا أَن يكون العادلون والصالحون، وبالجملة
ذوو الفضائل يعذبون على فضائلهم. ولذلك يكون الظلم الواقع بهؤلاءِ فخرا
لهم وكرامة ليست يسيرة. ولذلك ترى كثيراً من ملوك الجور يقصدون إِهانة
العلماءُ بالضرب وغير ذلك من الشر، فيكون ذلك فخرا لهم في الحياة وبعد
الممات، كما عرض لمالك وغيره من الفقهاءِ. وكذلك المقتولون من هؤلاءِ يعرض
لهم من ذلك بعد الموت كرامة عظيمة، مثل ما نال أَصحاب عيسى عليه السلام
بعد موتهم من الكرامة من التابعين لهم. وبالجملة كل من أُوذي على شيءِ
يكرم عليه الإِنسان فهو يستفيد بتلك الأَذية كرامة عظيمة. ومن الظلم
العظيم أَن يكون نوعا من الظلم مبتدعا لم يفعله أَحد غيره لا قبله ولا
بعده. ومما يعظم به الظلم أَن يكون هو أَول من فعله، فاقتدى به كل من أَتى
بعده ففعل ذلك الفعل، كما قيل في هابيل وقابيل ومن الظلم العظيم إِلحاق
الغرامة والخسران على الذين يتولون إِيصال الخيرات إِلى الناس مثل الظلم
الذي يقع على واضعي السنن. ومن الظلم العظيم الذي يوجب العقوبات العظيمة
في الشرائع المكتوبة مثل الإِلقاء إِلى السباع عند بعض الأُمم. ومن الظلم
العظيم الظلمُ الذي يقع من المرءِ بقرابته وخاصته لأَن ذلك يكون لبغضهم
والنفور عنهم. وأَذية القرابة وبغضهم إِنما يحمل عليه إِفراط الشرارة. ومن
الظلم العظيم الغدر بالأَمانات والفجور في الأَيمان ونقض العهود وما أَشبه
ذلك من الأٌمور التي تقتص في الأَخبار المكتوبة ولذلك كانت عقوبة هؤلاءِ
ليست كعقوبة سائر الظالمين، بل يفضحون مع العقوبة على رءُوس الأَشهاد مثل
عقاب شهداءِ الزور، فإِنه ليس يقتصر على عقابهم دون أَن يفضحوا في مجالس
الحكام وتسخم وجوههم. ولذلك زيد في عقاب الفرية عندنا التفسيق ورد
الشهادة. وأَقبح ما تكون الخيانة والغدر لمن تقدم منه إِحسان للغادر
والخائن. والذي يرائي بأَفعال الخير، وقصده الشر، هو من هذا النوع. والظلم
في السنن الغير المكتوبة، أَعني تعديها، أَعظم من الظلم في السنن
المكتوبة؛ وذلك أَن السنن الغير المكتوبة كأَنها شيء يضطر إِليها
الإِنسان، إِذ كانت كل الأَمر الطبيعي له، مثل بر الوالدين وشكر المنعم.
وأَما السنن المكتوبة فليس هي باضطرار للإِنسان. وإِن تعدى السنة المكتوبة
فظلم ظلما مستبشعا فهو ظلم عظيم مثل قتل الأَطفال والنساءِ. والغرامة في
الأَشياءِ التي ليس فيها غرامة في السنة المكتوبة من الظلم العظيم. ولذلك
كان أَقوى الأَسباب في فساد الرياسات.
قال: فقد تبين من هذا القول الظلم العظيم والصغير، إِذ الصغير ضد العظيم،
والشيءُ يعرف بمعرفة ضده.
وقد ينبغي أَن نقول في التصديقات التي تسمى غير صناعية، أَعني التي ليس
تكون عن قياس خطبي أَصلا، فإِن أَليق المواضع بذكرها هو هذا الموضع، إِذ
كانت أَخص بالمشاجرية منها بالإِثنين الباقيين من أَجناس الأَشياءِ
الخطبية، أَعني المشاورية والمنافرية.
وهذه التصديقات الغير الصناعية هي خمسة في العدد: أَحدها السنن، والثاني
الشهود، والثالث العقود، والرابع العذاب، والخامس الأَيمان.
والكلام فيها هاهنا إِنما هو كيف يستعمل واحد واحد منها في الشكاية
والاعتذار.
فلنقل أَولا في السنن فنقول إِن السنن لما كانت منها عامة ومنها
مكتوبة، فقد يجب إِن كانت السنن المكتوبة مضادة للشيءِ الذي يَقصد تثبيتَه
الشاكي أَو المعتذر أَن يحتج بالسنة العامة الموافقة له، أَعني المضادة
للسنة المكتوبة، ويقويها، ويزيف السنة المكتوبة. فأَحد المواضع التي ذكر
مما تزيف به السنة المكتوبة هو أَن يقول: إِن الواجب هو الأَخذ بالسنن
الغير المكتوبة، لأَن الإِنسان إِذا اقتصر على ما توجبه السنة المكتوبة لم
يكن محسنا ولا حليما ولا صفوحا، إِذ كان الإِنسان إِنما يوصف بهذه
الأَشياءِ إِذا اقتدى بالسنة العامة على ما تبين، وبالجملة فإِنما يتطرق
المدح والإِكرام من قبل السنن الغير المكتوبة، فاعل الواجب لا يمدح. ولذلك
لا يسمى من يعطي القدر الواجب من المال في السنة المكتوبة سخيا.
وموضع ثان وهو أَن يقول: إِن السنن المكتوبة إِنما يقتصر عليها العامة من
الناس الذين لا روية عندهم، وذلك أَنها أُمور مفروغ منها، فأَما الاقتداءُ
بالسنن الغير المكتوبة وتقديرها فهو لذوي الروية والخواص من الناس.
وموضع ثالث: وهو أَن السنن المكتوبة شاقة إِذ كانت تقصر الإِنسان على
أَشياء محدودة، والسنن العامة ملائمة لطبائع الإِنسان وهو أَهم.
وموضع رابع: وهو أَن السنن المكتوبة كثيرا ما يكون تركها أَنفع وأَفضل
وأَزيد في الخير، إِذ كان الشيءُ المحدود لا يلائم كل إِنسان ولا في كل
حين. وأَما السنن الغير المكتوبة فقد تقدر تقديرا يلائم كل إِنسان وفي كل
زمان.
وموضع خامس وهو: أَن السنة الغير المكتوبة أَبدية غير متغيرة لأَنها في
طبيعة الناس، والسنن المكتوبة متبدلة ومتغيرة. وحكى عن امرأَة مشهورة
عندهم أَنها اعتذرت عن رجل دفن عندهم على غير السنة المكتوبة بأَن قالت:
لم أَكن لأَدفنه على سنة تكون اليوم ولا تكون غدا، بل على السنة التي لا
تبيد أَبداً.
وموضع سادس وهو أَن السنة المكتوبة مظنونة، إِذ كانت مقبولة من الغير،
وإِنما هي معروفة بالطبع. ومن القول النافع في ذلك أَن نقول: أَن نقول:
إِن السنة العامة هي التي يفعل بها الحاكم أَفعالا مختلفة بحسب النافع
لشخص شخص ووقت وقت، والحاكم هو بمنزلة المخلص للفضة من الخبث، ولذلك قد
يجب على الحاكم الفاضل أَلا يقتصر على السنة المكتوبة فقط، بل يستعمل
السنتين معا حتى يتخلص له الحق في ذلك، ويتقرر لديه القول الخاص بالقضية
التي يحكم فيها. ولذلك متى حكم في شيء، وكانت السنة المكتوبة ضد الغير
المكتوبة، أَو كانت فيه سنتان متضادتان، فقد يجب على الحاكم أَن يستعمل
السنة القديمة أَحيانا، أَعني الغير المكتوبة، في موضع، ويطرحها في موضع
آخر؛ وكذلك الحال في السنة المكتوبة. فإِن بهذا الوجه يسقط التعارض الذي
بينهما في الظاهر ويصح الجمع. وهذا الذي قاله بيّن من فعل الفقهاءِ - وهذا
عندنا - في السنن المكتوبة المتضادة.
قال: ومتى أَشكل عليه وجه الجمع، فقد يجب عليه أَن يتوقف ولا ينفذ إِحدى
السنتين، بل يرجئ الحكم حتى يتبين له موضع الشك والشبهة بين السنتين، إِما
العامة النافعة وإِما المكتوبة الواجبة.
فهذا جملة ما قيل هاهنا في دفع السنن المكتوبة إِذا كانت مضادة للشيءِ
الذي يقصد تثبيته.
وأَما إِذا كانت السنة المكتوبة موافقة للأَمر المقصود تثبيته، والعامة
مضادة، فأَحد ما تزيف به السنة الغير المكتوبة المضادة أَن يقال: إِن
السنة العامة متبدلة الموضوع ومتبدلة الأَوقات، فهي بالجملة غير غير
محدودة، بل تحتاج إِلى استنباط وتحديد، وأَما المكتوبة فهي مفروغ منها.
فإِذا كان المضاد في السنة الغير المكتوبة متوهما وغير معلوم بعد، وكان
الموافق لنا في السنة المكتوبة مصرحا به، فقد ينبغي أَن يعتقد أَنه ليس
يجب أَن كون الحكم يتعدى به السنة المكتوبة.
وموضع آخر تزيف به السنة الغير المكتوبة: وهو أَن السنة الغير المكتوبة
تقتضي حكما عاما مثل الإِحسان إِلى من أَحسن إِليك، والمكتوبة تقتضي حكما
خاصا وهو مقدار ذلك الإِحسان ووقته. والعام الكلي ليس يفعله أَحد، وإِنما
يفعل الجزئي. والذي يفعل، هو الذي يجب أَن يمتثل.
وموضع آخر يقوي السنة المكتوبة: وهو أَن الوضع للسنة المكتوبة إِن كان
واجبا، فاستعمالها واجب؛ وإِلا فأَيّ فائدة في وضع شيء لا يستعمل.
وموضع آخر قوي في تثبيت السنة المكتوبة: وهو أَن واضعها نسبته
إِلى الجمهور في تقدمه بعلم المصالح نسبة الطبيب إِلى الذين يطبهم،
وبالجملة نسبة أَهل الصنائع إِلى من لم يكن من أَهل تلك الصناعة. وكما أَن
الطبيب ليس ينبغي للإِنسان العليل أَن يتوانى أَو يتردد في قبوله قوله أَو
تأوله، كذلك الحال في قبول قول الواضع للسنة المكتوبة، بل المضرة في
مخالفة واضع السنن أَشد من المضرة في مخالفة الطبيب. وذلك أَن مخالفة
الطبيب إِنما تلحق منها مضرة لواحد من الناس، ومخالفة واضع السنن يلحق منه
هلاك أَهل المدينة بأَسرها.
وموضع آخر: وهو أَن الذين ينصبون حكاما في المدن إِنما هم الذين علموا
السنن المكتوبة، لا السنن الغير المكتوبة. فإِن كل الجمهور يستوون في
إِدراكها. وإِذا كان ذلك كذلك، فواجب أَن تمتثل السنن المكتوبة، وإِلا كان
استعمال الحكام عبثا وباطلا.
فهذا جملة ما قاله في السنن.
القول في الشهود
فأَما الشهود، فمنهم قوم قد سلفوا، ومنهم حدث وموجودون. ومن الحدث من يشارك المشهود له في الخير الذي يرجوه أَو الشر الذي يخافه. وأَعني بالشهود القدماء الأَسلاف المعروفين المقبولين عند جمهور الناس المشهور فضلهم. فهؤلاءِ تقبل شهادتهم على الأَشياءِ السالفة سواء أَخبروا أَنهم عاينوها أَو لم يخبروا بذلك، لأَنه يحمل أَمرهم على الجملة فيما أَخبروا به على التصديق. والشهادات: إِما شهادة على أَشياء سالفة وهي التي لم يدركها أَكثر الموجودين في ذلك الوقت، وإِما شهادة على أُمور موجودة، وإِما شهادة على أُمور مستقبلة. فأَما الأَشياءُ السالفة فإِن الشهود عليها هم الأَسلاف لا محالة. وأَما الأَشياءُ الموجودة في زماننا فإِن الشهود عليها مَنْ في زماننا. وأَما الأَشياءُ المستقبلة فقد يكون الشهود عليها قوما تقدموا وقوما موجودين في زماننا هذا. والشهود على الأَشياء المستقبلة صنفان: الكهان سواء كان تكهنهم بصناعة أَو بغير صناعة، وذوو الأَمثلة السائرة التي تمنع أَو تأذن في العمل، مثل ما يقال: صل رحمك، فإِن صاحب الشرع عليه السلام قد قال: صلة الرحم تزيد في العمر. وأَشباه هذا. فأَما الشهود الموجودون فالمقبولون والمعمول بشهادتهم هم الذين امتحنهم أَهل معارفهم، أَعني جيرانهم أَو قرابتهم أَو أَهل مدينتهم، فوجدوها مقيمين على الأَحوال التي تقبل بها شهادتهم غير منتقلين عنها. وأَما الشهود من الأَسلاف فقد استقر عمرهم على القبول، فلذلك ليس يحتاجون إِلى الامتحان، وأَعني بالقبول إِما عدالتهم إِن شهدوا على أَشياء ماضية، وإِما صحة وجود الملكات لهم التي يخبرون بها عن الأُمور المستقبلة إِن كانت شهادتهم في أُمور مستقبلة. ومما يشترط في قبول شهادة الشهود الحدث أَلا يشاركوا المشهود له في خير يرجوه ولا شر يتوقعه، مثل أَن يكونوا آباء للمشهود له أَو أَبناء أَو قرابة. وذلك أَنه إِن أَراد منهم أَن يكذبوا، كما يقول أَرسطو، ربما كذبوا. وأَما الأَسلاف فليس يتصور فيهم هذا إِذ قد عدموا. والشهود الحدث إِنما تقبل شهادتهم إِذا شهدوا أَن الأَمر كان أَو لم يكن، وليس تقبل شهادتهم على أَن الأَمر عدل أَو جور. وأَما الأَسلاف فإِنه تقبل في ذلك شهادتهم، إِما لأَنهم لا يتهمون، لأَنهم ليسوا مشاركين للشهود له؛ وإِما لأَن قولهم يحمل على أَن الحاكم كان كذلك في الزمان السالف. والتصديقات قد تقع من قبل الشهادات، وقد تقع من قبل قرائن الأَحوال المشاكلة، فتقوم مقام الشهادات والحكم بقرائن الأَحوال المشاكلة هو من فعل ذوي الفطانة والحذق من الحكام. ولذلك ينبغي للحاكم أَلا يغلط في المشاكلات المموهة كما لا يغلط الصيرفي في الفضة المغشوشة.وإِذا كانت هذه الأَحوال قد توقف الحاكم على الأَمر الصادق نفسه، مع كون الشهادة الكاذبة مضادة لها، فهي أَحرى أَن توقف عليه حيث لا تكون هنالك شهادة، أَو حيث تكون الشهادة موافقة لها ولذلك كانت هذه الأَحوال تقوم عند الحكام مقام الشهود. فإِنه لا خلاف بين أَن يحكم بالشهود أَو يحكم بهذه الأَحوال المشاكلة التي تقترن بالمتكلمين. وهذه الأَحوال هي غير الضمائر، ولذلك عدت مع الشهادات.والشهادات: منها ما هي في الأَمر المتنازع فيه، ومنها ما هي في
الشهود، ومنها ما هي في المتخاصمين. والشهادة على الشهود: منها ما هي في
تقويتهم، ومنها ما هي في توهينهم. وأَما الشهادة على المتخاصمين فهي
بتعديل أَحدهما وتجريح الآخر. والشهادة على الشهود تكون إِما أَنه صديق
أَو عدو، وإِما أَنه وسط بين المدعى والمدعى عليه، وهو أَلا يكون صديقا
لأَحدهما ولا عدوا للآخر. وهنا فصول أُخر في الشهود سوى هذه الفصول سيقال
فيها حيث يقال في المواضع العامة التي تعمل منها الضمائر وذلك في المقالة
الثانية من هذا الكتاب.
فهذا جملة ما قاله في الشهادات.
القول في العقود
والعقود هي الشرائط التي يتفق عليها بعض الناس مع بعض. والشرائط التي يتفق عليها إِنما هي نافعة في أَمرين: أَحدهما في تخسيس المعترِف بها وذمه، إِذا لم يقف عندها وهو مصدق بها، وفي مدحه إِذا وفي بها. والمنفعة الثانية في تصديق المدعى وتكذيب المدعى عليه إِذا أَنكرها. وليس في هذا الموضع فرق بينها وبين الشهود، وذلك أَن الشروط إِذا كانت مكتوبة أَو شهد عليها الشهود قامت مقام الشهود في تبيين الأَمر الذي فيه الخصومة وتبيين حال الذين يتخاصمون، أَعني كيف أَحوالهم في الفضيلة والرذيلة. وذلك أَن التزام الشرط يدل على الفضيلة، ومخالفته تدل على الرذيلة. وإِذا اعترف الخصم بالشرط وادعى أَنه لا يلزمه، فقد يحتاج المتكلم أَن يقنع في وجوب لزوم الشرط بأَن يقول: الشرط سنة خاصية وجزئية فيجب الوقوف عنده على الجهة التي يجب الوقوف عند السنن. وإِذا كانت السنة مخالفة للشرط، قال: إِن السنة ليس تحكم على الشرط ولا ترأَسه، لأَن السنة تقتضي مصلحة عامة والشرط مصلحة خاصة، والخاص يحكم على العام؛ فإِذن الشرط هو الذي يرأَس السنة، لا السنة ترأَس الشرط. وإِن لم تكن مخالفة له، أَعني للشرط، قال: إِن الشرط نوع من السنة، إِن كانت السنة موضوعة عندهم بالاصطلاح، أَو أَن السنة توجب الوقوف عند الشرط، إِن كانت السنة عندهم بوحي من الله.وموضع آخر: وهو أَن يقول إِن الشروط هي التي تقتضي المصالح الخاصة بحسب شخص شخص ووقت وقت. فإِن لم يوقف عند الشرائط، بطلت المصالح. وإِن الشرط هو الذي يلتزمه الإِنسان باختياره وعن رويته. وما هو بهذه الصفة فلا يعذر في أَلا يقف عنده. إِلى غير ذلك من المواضع التي تشبه هذه مما يطول الكلام بذكرها إِن ريم استقصاؤها في هذا الموضع.
فهذا ما قاله في الأَشياءِ التي تثبت بها الشروط. وأَما الأَشياءُ التي تزيف منها الشروط إِذا رأَى المتكلم أَن الأَصوب والأَصلح تزييف الشروط فهي: السنن المكتوبة والسنن العامة؛ مثل أَن يقول: إِن السنن المكتوبة أَشد مشاكلة ومناسبة للمصالح، لأَن السنة المكتوبة مشتركة، والمشتركة أَعم صلاحا من الخاصة التي هي الشرط. والصلاح العام أَهم من الصلاح الخاص.
وموضع آخر وهو أَن الشروط يمكن أَن يلتزمها الإِنسان لمكان مخالطة وخديعة تجرى عليه، وما توجبه السنن ليس يمكن فيه الخديعة، فالسنن أَولى من الشروط.
وموضع آخر: وهو أَن يقول إِن الحاكم هو الفاحص عن العدل والكاشف عنه، أَعني العدل الذي يكون بحسب المدينة، ولذلك يجب عليه أَن يفحص عن العدل الذي اشترطاه في أَنفسهما، أَعني المتعاقدين. فإِن كان عدلا في المدينة، تركهما على الشرط. وإِن كان غير عدل أَبطل الشرط.
وأَيضا فإشن السنن لا توضع عن قسر ولا عن غلط؛ والشروط قد يمكن ذلك فيها. وبالجملة فينبغي أَن نتبع أَضداد الشرط في السنن، فإِن لم نلفه في السنة المكتوبة، فربما أَلفناه في السنة العامة، فزيفناه بذلك. وإِن أَلفيناه في المكتوبة احتججنا في إِبطاله بها سواء كانت السنة سنة تلك المدينة أَو سنة لمدينة ترأَس تلك المدينة.
ومما يبطل العقود أَن تكون هنالك عقود مضادة إِما متقدمة عليها وإِما متأَخرة عنها. والأَواخر أَبداً في الأَكثر تقضي على الأَوائل. وقد تقضي المتقدمة على المتأَخرة، إِذا كانت المتقدمة صحيحة، والمتأَخرة مغلطة خادعة.
وأَيضا فينبغي للذي يزيف الشرط أَن يتأَمل أَلفاظه، فإِن كان فيها ما يمكن تحريفه، حرفه وأَخرجه عن المفهوم الذي يقتضي علة الحاكم. وهذا إِنما يمكن أَن يفعله من كان له بصر بالأَلفاظ المشتركة والمعاني المتشابهة.
فهذا آخر ما قاله في العقود.
القول في العذاب
قال: وأَما التقرير بالعذاب فإِنها شهادة ما لقول المعذب، وفيه له تصديق ما، لأَنه يخاف إِن كذب أَن تعاد عليه العقوبة، ولما تخيل أَيضا أَن في الصدق النجاة من الشر الواقع به، إِلا أَنه صدق مُكره عليه. ولذلك ( لا) يعسر إِدراك الأَشياء التي بها يمكن أَن يثبت الإِقرار الذي يكون تحت العذاب إِذا كان موافقا للمتكلم، وأَن يزيف إِذا كان موافقا للخصم. إِلا أَن تزييفه ونقضه هو حق في نفسه. فإِن المعذبين لمكان الإِكراه ليس يكون اعترافهم بالكاذب أَقل من اعترافهم بالصادق، بل قد يعترفون بالذي يطلب منهم لمكان النجاة من العذاب وإِن كان كاذبا. وأَيضا فإِنهم إِذا صبروا على العذاب ولم يقولوا الحق فقد يبادرون إِلى الكاذب ليظن به أَنه هو الصادق، ليستريحوا من العذاب بذلك سريعا. ولذلك ما ينبغي للحكام أَن لا يستعملوا هذا النوع من الاستدلال بل يعودون فيستعملون الدلالات الأُخر. فإِن كثيراً من الناس لصحة أَبدانهم وعزة نفوسهم يصبرون على الأَذى صبراً شديداً فلا يعترفون بالصادق. وأَما الجبناءُ وأَهل الضعف فقد يقرون على أَنفسهم بالكاذب قبل أَن يروا الشدائد. ولذلك ليس في العذاب شيءٌ يوثق به. ولمكان هذا درأَ الشرع عندنا الحدود التي تتعلق بالإِقرارات التي تحت الإِكراه.القول في الأَيمان
قال: وأَما الأَيمان فإِنها تستعمل لمكان أَربعة أَشياء، وذلك أَن الحالف إِما أَن يحلف ليعطى شيئا ويأْخذ شيئا، مثل ما يكون في البيوع. وأَما أَلا يعطى شيئا ولا يأْخذ شيئا. وإِما أَن يعطى ولا يأْخذ. وإِما أَن يأْخذ ولا يعطى. وحلف الإِنسان ليعطى إِنما يكون لأَشياء أُخر ضارة به، أَعني إِن أَمسك ولم يعط. واليمين إِما أَن تكون من المدعى أَو المدعى عليه. وليس في اليمين شيءٌ من التصديق، إِذا علم أَن الحالف رجل فاجر. وإِذا لزمت اليمين أَحد الخصمين فنكل، فقد لزمته الحجة. لأَن المطالبة باليمين تَحد على الصدق. وإِذا عجز المتحدّى، فقد لزمته الحجة.
قال: ولما كان المطالب باليمين متردداً بين مكروهين أَحدهما مما يناله من قبل اليمين - إِذا حلف كاذبا - وهو الاستهانة بالله و حرماته؛ والثاني المكروه الذي يناله من الأَخذ منه أَو الإِعطاء، فهو أَبداً إِنما يفعل أَقل المكروهين ضررا عنده. فلذلك قد يصدق بعض الناس إِذا حلف، ويكذب بعضهم. وهذا أَحد ما يزيف به الاحتجاج بالأَيمان.
قال: وقد يُصدق الرجل الفاضل ويُرى أَنه لمحق، وإِن لم يحلف. لكن تصديقه ليس هو لمكان أَنه لم يحلف، ولكن لمكان فضيلته، ومن أَجل أَنه ليس ممن يحنث ولا يفجر بغير يمين، فضلا مع اليمين.
قال: وأَما التحدي باليمين فإِنه كثيراً ما يكون من الرجل الفاسق نحو الثقة الأَمين، لأَن تحرج الثقة عن اليمين مما يوقع التصديق بقول الفاسق.
قال: وهذا هو مثل أَن يغلب المتهور المتوقي أَو يدعوه إِلى أَن يغلبه ويتحداه بذلك. فإِن المتوقي يتجنبه.
قال: ولكن ليس للثقة الأَمين، وإِن كان الأَمر هكذا، أَن يأْخذ بغير يمين، إِذا كان خصمه ليس يراه ثقة، بل ليس يأْخذ إِلا أَن يحلف.
قال: وبذلك كان يحكم فلان لرجل مشهور في الحكام عندهم. وكذلك هي السنة عندنا قال: والثقة الأَمين، إِذا اشتد عليه إِتيان اليمين عند الدعوى عليه، فإِن أَحب أَن يعطى ويكرم الله ولا يحلف، فقد يجب له أَلا ينكر الدعوى الكاذبة عندما يُعطِى ما طولب به. فإِنه إِن أَنكر وأَعطى، أَوهم أَن المدعى محق وأَنه إِنما أَعطى لمكان اليمين الفاجرة التي لزمته، ولذلك ليس ينبغي أَن يلجئ نفسه إِلى أَن يُطالب باليمين، لأَنه إِذا طولب باليمين فلم يحلف ظن به الكذب.
قال: وهو معلوم عند الحكومة في المشاجرة الخاصة والعامة كيف
يعتذر المرءُ إِذا خالف يمينه أَو يعتذر عنه، وكيف يؤنب مخالف اليمين
ويعذل. وذلك أَن الأَشياءَ التي يخالف فيها اليمين هي تلك الأَشياءُ
الأَربعة التي يحلف عليها، وهي التي يهواها إِنسان إِنسان من الناس، وذلك
إِما أَن يأَخذ ويعطى، وإِما أَلا يأخذ ولا يعطى، وإِما أَن يعطى ولا
يأْخذ، وإِما أَن يأْخذ ولا يعطى. فإِذا حلف المرءُ على واحد من هذه
الأَربعة، فلا يخلو أَن يكون القول الذي يستعمله في تثبيت ذلك الشيء إِما
موافقا لما حلف عليه وإِما مخالفا، وذلك يكون إِذا جحد اليمين.
فإِن كان مخالفا، فإِنَّ أَحَدَ ما يؤنب به المخالف لليمين أَن يقال: إِن
اليمين هي شريعة من الشرائع، فمتى خالفها المرءُ طوعا وجحدها، فقد ظلم؛
لأَن الظلم هو مخالفة للشريعة طوعا.
وأَما المعتذر عن مخالفة اليمين فقد يعتذر أَن يمينه كانت بإِكراه أَو
بغلط أَو بغفلة، وأَنه إِذ حلف لم ينو ذلك الشيءَ الذي خالفه، وإِنما نوى
غيره، وأَن الذي حمله على اليمين هو اللجاج ومخالفة الخصم وضيق الصدر
والحرج، وبالجملة التهيؤ الموجود فيه لسبوق اليمين وبدورها والمسارعة
إِليها وإِلى الإِنكار والجحود.
ومما يستعمل في التثبيت على السنن والأَيمان والتمسك بها أَن يقال: إِنه
قد يجب عليكم أَن تثبتوا على أَيمانكم ولا تخالفوها، فإِن اليمين هو حكم
شرعي أَلزمه المرءُ نفسه طوعا وعن علم، فقد يجب عليه أَلا يخالفه. وأَما
أُولئك الذين يحلفون لمكان الخديعة أَو الغفلة أَو التهيؤ للجحود
والمسارعة إِلى اليمين فلا يثبتون على أَيمانهم إِلى غير ذلك من أَشياء
تشبه هذا القول مما تعظم به اليمين وتفخم.
فهذا هو القول في التصديقات التي تكون بلا قياس، وجهات استعمالها في هذه
الصناعة.
وهنا انقضت المعاني التي تضمنتها هذه المقالة التي هي الأُولى.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله
المقالة الثانية
من الخطابة
قال: أَما من أَي أَصناف الأَقاويل يكون الإِذن والمنع والمدح والذم والشكاية والإِعتذار وأَي المقدمات والقضايا هي التي تؤخذ أَجزاءِ هذه الأَقاويل التي تفعل التصديق في هذه الثلاثة فقد قيل فيها في المقالة الأُولى. فإِن المخاطبات في الأُمور الجزئية إِنما تكون من أَجل هذه الأَغراض الستة التي ذكرناها وبالأَقيسة والمقدمات التي عددناها فيما سلف.ومن أَجل أَن الخطابة لا بد فيها من حاكم يرجح أَحد قولي المتخاطبين، إِذ كانت الأَقاويل المستعملة فيها غير يقينية، ولذلك احتيج إِلى الحكام في المشوريات أَكثر ذلك، إِذ كانت أُموراً ممكنة، وكذلك يحتاج إِليهم في التشاجر والمدح والذم، فقد ينبغي أَن ننظر هاهنا ليس في الأَقاويل المثبتة والمبطلة، بل وفي بيان الأَقاويل التي تفيد الحاكم الانفعالات التي تصيره إِلى الميل في الأَحكام.فإِنه قد يختلف تصديق الحاكم بكلام المتكلم، وتصديق المتكلم بحكم الحاكم إِذا عرف المتكلم أَي امرئ هو الحاكم في صداقته له أَو عداوته، وعرف الحاكم أَي امرئ هو المتكلم في فضيلته ومعرفته. أَما معرفة الحاكم بالمتكلم فغناءُ ذلك في الأَكثر إِنما هو في الأُمور المشورية. وأَما معرفة المتكلم بحال الحاكم فالانتفاع بذلك إِنما يكون أَكثر ذلك في الخصومات. وذلك أَنه ليست أَحكام الحكام على من أَحبوه أَو قَلَوْه حكما واحداً، ولا من كانوا عليه غضاباً أَو غير غضاب أَو خائفين منه أَو غير خائفين منه، بل توجد أَحكام الحكام تختلف بحسب هذا اختلافا كثيرا في القدر والمبلغ. فإِذا حكموا على من يحبون، فإِما أَلا يخسروه شيئا وإِما أَن يخسروه اليسير. وأَما حكمهم لمن يبغضون فخلاف ذلك. وكذلك فرق بين أَن يحكم الحاكم وهو منشرح الصدر للمتكلم حسن الظن به وبين أَن يحكم وهو ضيق الصدر مكترث به.
قال: والمتكلمون يكونون مصدقين في أَقاويلهم أَكثر ذلك لعلل
ثلاث؛ لأَنه قد يُصدق المرءُ بهذه الثلاث دون قول مثبت. وهذه الثلاث هي:
المعرفة والفضيلة والإِلف، أَعني أَن لا يكون مستوحشا من الذي يشير عليه
إِما لمكان جهله به أَو مباينته له في الجنس أَو المكان أَو اللسان.
والمشيرون يصيرون غير مصدقين ومكذبين إِما من أَجل عدم هذه الأَحوال
الثلاثة فيهم أَو عدم بعضها، لأَنهم إِما أَن يكونوا لا يشيرون برأْي صواب
لمكان جهلهم وخطائهم، أَعني أَنهم يشيرون بما لا ينتفع به لضعف رأْيهم.
وإِما أَن يكونوا عارفين، لكنهم يمنعهم من الإِشارة بالصواب الخبث
والشرارة. وإِما أَن يكونوا عارفين ذوي فضائل، لكن يكونون مستوحشين من
الذين يشيرون عليهم. وذلك أَنهم إِذا كانوا بهذه الصفة، أَمكنهم أَن
يعرفوا الأَمر الأَفضل فلا يشيرون به. وهو بين أَنه ليس سوى هذه الخلال
الثلاث خلة إِذا وجدت للمتكلم أَمكن أَن يكون بها مصدقا عند السامعين.
فأَما من أَين يعرف المرءُ أَن المتكلم بهذه الحال أَو يثبت أَنه على هذه
الحال عند من لا يعرف ذلك فمن الأَشياءِ التي ذكرت في باب المديح، أَعني
أَنه ذو معرفة وفضيلة.
وأَما أَنه متأَنس وصديق فإِن القول فيها هو جزءٌ من القول في المقدمات
التي يثبت بها الانفعالات التي تختلف أَحكام الحكام بسببها وهي التي
تلزمها إِما اللذة وإِما الأَذى، مثل الغضب والرحمة والخوف وأَضداد هذه
وما أَشبه ذلك.
قال: وقد ينبغي أَن نقول فيها هاهنا وذلك يكون بان ننظر من كل واحد من هذه
الانفعالات في ثلاثة أَشياء، أَعني في الأَشياءِ الفاعلة لذلك الانفعال،
وفي الناس المستعدين لذلك الانفعال، وعلى من يقع ذلك الانفعال غالبا.
ومثال ذلك: إِذا نظرنا في الغضب، أَن نقول: بأَية حالة يكون المرءُ غضوبا،
وما الأَشياءُ الفاعلة للغضب، ومَنْ القوم الذي يغضب عليهم بالطبع. فإِن
الغضب إِنما يوجد ولا باجتماع هذه الثلاث. وإِذا وجد بعضها ولم يوجد بعض،
فليس يوجد الغضب ولا بد. وبالجملة فيفعل في هذا الجنس مثل ما فعل في
الأَبواب المتقدمة، أَعني في باب الخصومات، وفي باب المشورة، حيث حددنا
الأَشياءَ التي يقصد تثبيتها، ثم الأَشياء التي بها يلتئم وجودها، أَعني
النافع أَو الضار أَو العدل أَو الجور. والاثنان من هذه الثلاثة هي التي
تأْتلف منها المقدمات التي إِذا خوطب بها الإِنسان حركته إِلى ذلك
الانفعال، أَعني الفاعلة له وبمن يقع ذلك الانفعال. وأَما الذين هم معدون
لذلك الانفعال، فإِنما يوجد من أَحوالهم التي هم بها معدون أَنهم قد
انفعلوا لا أَن تحركوا بذلك إِلى ذلك الانفعال. ومثال ذلك أَن المرءَ
إِنما يحركه إِلى الغضب إِذا وصفت له حضور الأَشياء الفاعلة للغضب والمرء
الذي يجب أَن يغضب عليه. فأَما الأَحوال التي بها يكون المرء معدا لأَن
يغضب، فإِنما يثبت بها أَنه قد غضب. لكن معرفة هذه الأَحوال نافعة لمن
يريد أَن يُغضِب، لأَنه يعرف الوقت الذي يكون فيه المرءُ مستعدا لقبول
القول الذي يحركه لذلك الانفعال.
قال: والغضب هو حزن أَو أَثر نفساني يكون عنه شوق من النفس إِلى عقوبة ترى
واجبة بالمغضوب عليه من أَجل احتقار منه بالمرءِ الغاضب أَو بمن هو بسببه
ومتصل به.
والاحتقار هو الذي يسميه أَرسطو صغر النفس لأَن نفس المحتقر به كأَنها
تصغر بالأَشياءِ الصغيرة التي يتوهم فيها.
وإِذا كان هذا هو حد الغضب، فالغضب إِنما يكون من إِنسان مشار إِليه أَو
ناس مشارين إِليهم على إِنسان مشار إِليه أَو ناس مشارين إِليهم لا على
الإِنسان الكلي وذلك لشيء فعله المغضوب عليه بالغاضب أَو بأَحد ممن هو
بسببه.
وكل غضب فيلزمه أَبدا شيء من اللذة من قبل أَن الغاضب يؤمل أَن ينتقم من
المغضوب عليه. وإِذا أَمل التذ، لأَن هذا الأَمل هو الظن بأَنه سيظفر من
المغضوب عليه بما هو كالممتنع على غير، وهو العقوبة التي تتوق نفسه
إِليها. ولذلك قد يشرف الغاضب في نفسه بما يتخيل فيها من القدرة على
العقوبة، ولذلك ليس يغضب على من هو فوق رتبته جدا ولا على من هو دونه جدا.
قال: وما أَحسن ما قال الشعراء في الغضب: إِن الذي يعتلج منه في
النفس شيء أَحلى من العسل والشهد، وإِن الذي يغشى الفكر منه هو شيء شبيه
بالدخان. ولذلك لا يعقل الغضبان ولا يفهم. وإِنما قيل فيه: إِنه أَحلى من
العسل، لمكان اللذة التي تكون فيه عن تخيل الانتقام لأَن تخيل الشيء
المتشوق وتردده في النفس لذيذ، إِذا لم يكن هنالك فكر يفهم معه شيء مكروه
مقترن بالمتشوق، ولا شيء يعوق، ولكن يقوى حصول إِمكانه، كالحال في
الخيالات التي يلتذ بها في النوم.
قال: والاحتقار بالشيءِ والتهاون به يكون من قبل أَن الشيءَ لا قدر له ولا
يستحق أَنيعتنى به، أَعني أَن يقتنى إِن كان خيرا أَو يحتال في دفعه إِن
كان شرا. ولذلك كانت الخيارات والشرور جميعا يظن بها أَنها مستوجبات
للعناية بها. وكذلك الأُمور اللازمة للخير والشر مثل الخوف للشر والتأْميل
للخير هي أَيضا معتنى بها. وإِنما يرى الناس أَنه لا يستحق شيئا من
العناية ما ظن به أَنه ليس فيه خير يرتجى ولا شر يتقى؛ وإِن كان، فنزر
قليل جدا.
وأَنواع الاحتقار، وهو الذي يسميه أَرسطو صغر النفس، ثلاثة: الإِهانة،
والسخرية والطَّنْز، والشتيمة.
فإِن الذي يهان، وهو الذي يفعل به ضد أَفعال الكرامة، محتقر. وإِنما
يتهاون المرءُ بالذي يرى أَنه ليس أَهلا لشيء. وكذلك الذي يطنز به هو
محتقر أَيضا، إِذا كان الطنز بالشيءِ يعوق عن تشوقه وإِرادته.
والطنز الذي بهذه الصفة هو الطنز الذي ليس يقصد به فاعله شيئا يستفيده سوى
مضرة المطنوز به. وذلك أَنه لما كان المطنوز به محتقرا، فهو بيّن أَنه لا
يَخاف منه ضرراً. ولو ظن ذلك، لخاف فلم يحتقره. وأَما الذين يطنزون
لينالوا بالطنز منفعة مَا، فأُولئك إِنما ينبغي أَن يُسَموا مستعطفين
ومحتالين، مثل أَهل الدعابة الذين يتخذهم الملوك، وليس يدخلون في ذلك
الجنس، وإِنما يدخلون في جنس المحتالين.
وكذلك الشتيمة هي احتقار للمشتوم والشتيمة التي بهذه الصفة هي التزييف
والبهرجة التي يقصد بها أَذى المشتوم بالشيءِ الذي إِذا صرح به خزي به
المشتوم. وليس تكون الشتيمة التي بهذه الصفة إِلا إِذا كان الذي شتم به قد
وجد للمشتوم فيما سلف لا فيما يستقبل، وأَن يكون شتما قبيحا يخزى منه
المشتوم، وأَن يكون ليس يقصد به أَن يحصل منه للمشتوم منفعة ما، مثل الشتم
الذي يقصد به الأَدب، فإِن هذا ليس هو احتقاراً، وإِنما هو معاقبة. وإِنما
كان الشتم ملذاً، لأَن الشاتمين يظنون بأَنفسهم أَنهم أَفضل من المشتومين.
ولذلك ما يوجد الأَغنياءُ والأَحداث شتامين وفحاشين، لأَنهم يظنون
بأَنفسهم الفضيلة على غيرهم. وهذا من فعل الشاتمين بيّن. فإِن الشتيمة
احتقار. وإِنما يحتقر من ليس أَهلا لشيء، وهو الذي ليس له شيء من الكرامة،
لا من أَجل خير يرجى منه، ولا من أَجل شر يتوقى منه.
قال: والذين يظنون أَن لهم حقا واجبا على كثير من الناس في الحسب والقوة
والفضيلة، وبالجملة: في كل ما يفضل به إِنسان إِنسانا، مثل فضل الغنى على
الفقير، والبليغ على العي، وذي الرياسة على المرؤوس، أَو الذي يرى نفسه
مستعدا للرياسة وإِن لم يكن رئيسا، جميع هؤلاءِ معدون لأَن يغضبوا على
الناس من أَدنى شيء يتخيلونه فيهم من الاحتقار. ولذلك قيل إِن شدة
الاستشاطة والغضب توجد في أَبناءِ الملوك ومَن يتصل بهم الذين نشأُوا في
الترفه ولم يلقوا قط إِلا بما يسرهم من إِكرام الناس لهم والمعاملة
الجميلة. ويوجد في هذا الصنف مع شدة الاستشاطة أَشياءَ تلزم شدة الاستشاطة
مثل فرط الانتقام وأَلا يقنعوا من الجاني عليهم بالشيءِ اليسير إِلا
بالعقوبة العظيمة. وذلك أَنهم يمتعضون لعِظَم شأْنهم في أَنفسهم.
ومن الأَحوال التي إِذا كانت في الإِنسان صار بها معدا لأَن يغضب عليه أَن
يكون ذلك الإِنسان ممن يتوقع منه الإِحسان بعادة فلا يفعل ذلك إِما
بالإِنسان الذي عوده ذلك أَو بمن يتصل به. وذلك إِذا علم ذلك الإِنسان إِن
تركه ذلك كان بهوى منه، أَو علم أَنه يهوى أَن يترك ذلك وإِن لم يترك. وقد
يعد ترك الإِحسان المعتاد في فاعلات الغضب. وإِذا كان هذا هكذا، ففاعل
الغضب بالجملة إِنما هو الاحتقار أَو ما يظن أَنه احتقار.
والناس المستعدون للغضب هم الذين توجد فيهم أَحوال تخيل فيهم في
أَكثر ما يرد عليهم أَنه احتقار. والمستعدون لأَن يُغضب عليهم هم الذين
يخيل فيهم إِلى الغير أَن أَكثر الأَفعال التي تَصدر منهم هي احتقار.
وإِذ قد تبين بالجملة من أَجل أَي شيءٍ يكون الغضب ومَن الذين هم غضوبون
ومَن الذين يغضب عليهم، فقد يجب أَن نعدد هاهنا هذه الأَحوال. فمن
الأَحوال التي بها يكون المرءُ غضوبا أَن يكون الإِنسان يتشوق إِلى شيء
ويكون تشوقه إِليه مع غم وأَذى فإِن هؤلاءِ يسرع إِليهم الغضب، فُعِل
بأَحدهم شيء مُوجب للغضب أَو لم يفعل، لأَنه لضيق صدره يظن أَنه فعل به
ذلك. ومن هؤلاءِ الذين لهم أَشياء تؤذيهم، فهم يشتاقون إِلى زوال ذلك
المؤذي. فإِن هؤلاءِ يغضبون على كل شيء ومن كل شيء، مثال الذين يمسهم فقر
أَو مرض. فإِن هؤلاءِ يشتهون الصحة والأَشياء المستعملة في الصحة والثروة
والأَشياء المدركة بالثروة. ولذلك ليس يقال لما يتردد في نفوس هؤلاءِ من
هذه الشهوة أضنه سبب لأَن يقال فيهم إِنهم شهوانيون، بل ذلك سبب لأَن يقال
فيهم إِنهم ضجرون. وأَكثر ما يغضب هؤلاءِ على الذين يحتقرون الأَمر الواقع
بهم، مثل الذين يتهاونون بالوجع الذي يصيب العليل في حال إِصابته إِياه.
وكذلك الذين يتهاونون بالحاجة الماسة التي أَصابت إِنسانا ما في حال فقره.
ومثل من يتهاون بالجور الواقع على إِنسان ما. ومن هذا الجنس من يتهاون
بصديق المرءِ. وبالجملة فكل من يتهاون بما يؤذي الإِنسان ويحزنه أَو بما
يلذه ويسره. والإِنسان الذي أَخفق أَمله يسرع إِليه الغضب، لأَنه قد ظن
ظنا ما فأَخفق ظنه.
قال: وقد تبين من هذه الأَشياءِ في أَي أَحوال من أَحوال الإِنسان وعوارض
من عوارض نفسه، وفي أَي سن، وخلق يكون أَشد استعداداً للغضب، وعلى من
يغضبون، وبمن يهزأون ومن يعيرون إِذا كانوا في شيء شيء من هذه الأُمور.
أَما في الأَحوال فمثل غضب أُولي الرياسة على من لا رياسة له.
وأَما في العوارض فمثل غضب المغتمين على المسرورين.
وأَما في الخلق فمثل غضب الشجعان على الجبناءِ.
وأَما في السن فمثل غضب المشايخ على الشباب.
قال: وإِنما يشتم ويستهان بالذين تكون حالهم في أَفعالهم وأَقوالهم
وحالاتهم حال من لا ينتفع بشيء من تلك الأَفعال والأَقوال والأَحوال، أَو
يظن بهم ذلك. فإِنه إِذا اعتبر أَمر الشتيمة والاحتقار وجدت لا تتعدى هذا
الصنف. ولذلك قد يظن أَن ما يقع من الاستهانة والاستخفاف بالفضلاءِ
والحكماءِ أَنه أَمر واجب. لأَن الجمهور يرون أَنهم لا ينتفعون من
أَحوالهم بشيء، وكذلك سائر الفضائل التي هي غير نافعة، وخاصة ما كان منها
إِنما يحصل بعد تعب عظيم ويحفظ بعد حصوله بتعب عظيم أَيضا. وذلك أَن
الجمهور لما كانوا يعتقدون في أَمثال هؤلاءِ أَنه ليس لهم منفعة في ما
يقتنون من ذلك ولا شيء فيه قوة منفعة كان أَحرى أَن يظنوا أَنه ليس
ينتفعون منهم بتلك الأَشياء. لأَنهم إِذا لم ينفعوا أَنفسهم، فأَحرى أَلا
ينفعوا غيرهم. وإِذا رأَى الجمهور في كثير من هذه الأَشياءِ أَن لهم فيها
منفعة، وإِن كان لا ينتفع بها أَهلها، أَعني الذي يقتنونها، ربما
استعطفوهم واسترحموهم بعد التغيير، وذلك في وقت حاجتهم إِليه، واعتذروا
إِليهم مما سلف. وهذا من فعلهم إِنما ينتفعون به معهم إِذا كان التغيير
المتقدم لهم غير مفرط ولا خارج عن العادة. لأَنه إِذا كان مفرطا ظن بهم
أَنهم يستهزئون بهم في حال الاستعطاف والتودد.
قال: والذين يحسنون، ثم يقطعون إِحسانهم؛ والذين لا يكافئون المرءَ على
فعله بما يجب لذلك الفعل، أَو يفعلون معه ضد فعله؛ والذين يرون المحسنين
إِليهم بحال خسيسة، وذلك بأَن يرى الذي أَحسن إِليه أَن ذلك الإِحسان خسيس
أَو أَن قدره فوق ذلك؛ فإِن هؤلاءِ يغضب عليهم. وهذه الأَفعال كلها هي من
فاعلات الغضب، لأَنه يظن بهم أَنهم متهاونون.
قال: وهاهنا قوم يغضبون من التهاون الواقع بأُمور خسيسة لهم أَو بالتي هي
أَخس من الخسيسة وهي التي ليس يرى لها أَحد قدراً في شيء ولا يمكن فيها
كلام تعظم به أَصلا ولا يطالب أَحد بتعظيمها. وليس يجب أَن يكون الأَمر
كذلك، أَعني أَن يغضب المرءُ على من يحتقر منه الأُمور اليسيرة، بل إِنما
يجب أَن يقع الغضب على من احتقر من المرءِ أُموراً لها قدرٌ.
قال: والأَصدقاءُ قد يُغضب عليهم إِذا لم يقولوا في أَصدقائهم
قولا جميلا عندما ينالهم مكروه، أَو يمتعضون إِذا ذكروا بسوء. وأَكثر من
ذلك إِذا لم يحسنوا إِليهم إِذا مستهم حاجة أَو لم يألموا بما نزل بهم من
المكروه، ولذلك قيل:
يواسيك أَو يسليك أَو يتفجع.
وإِنما يغضب على هؤلاءِ عدم الارتماض بالمكروه الذي وقع بهم يدل على
الاستهانة بهم. وذلك أَن من المعلوم أَن الإِنسان يغضب إِذا أُوذي من
يعتني به، وكذلك يغضب على الصديق الذي يتهم صديقه ويسيء الظن به، وعلى
الذي يتهاون بما بلغه عنه من قول، لأَنهم في هذه الأَحوال يشبهون
الأَعداءَ. وذلك أَن الأَعداءَ هم الذين لا يمتعضون للمكروه الذي ينزل
بعدوهم ولا يسوءهم الشر النازل بهم. وأَما الأَصدقاءُ فيمضهم السوء النازل
بإِخوانهم ويتفجعون لذلك ويجزعون.
قال: وقد يغضب على الذين يتهاونون بأُمور خارجة عن الإِنسان، وتلك هي خمسة
أَصناف: أَحدها الذين يتهاونون بالذي تكرمه أَنت، فإِنك تغضب عليهم.
والثاني أَن يتهاون بالذي هو عندك متعجب منه ولا يتعجب منه. والثالث أَلا
يتعجب مما تحب أَنت أَن يكون متعجبا منه، وإِن لم يكن كذلك. والرابع أَن
يتهاون بالناس الذين تتعجب منهم أَو الذين يتعجبون منك. والخامس أَلا
يستحي المرءُ من الأَشياءِ التي تستحي منها وتحتقرها.
قال: وإِنما يشتد الغضب على الذين يتهاونون بهذه الأَصناف الخمسة، لأَن
الناس يرون فيهم أَنهم لا يعاونونهم على فعل الجميل ولا يؤازرونهم،
فيغضبون عليهم. وهذا الغضب مثل غضب الآباءِ على الأَبناءِ، أَعني أَنه
إِنما يغضبون من جهة أَنهم غير معاونين لهم على فعل الجميل. وقد يكون
الغضب على الذين يظن بهم أَنهم يتهاونون بواحد من هذه الأَصناف الخمسة،
وإِن لم يكن الأَمر كذلك في الحقيقة، وذلك يعرض كثيرا للنساءِ ذوات
الرياسات مع الذين يرأَسن عليهم لضعف تدبيرهن.
قال: ومما يفعل الغضب أَيضا النسيان للأَشياءِ المهمة عندك حفظها، كما
يعرض كثيرا للمرءِ أَن يغضب على من ينسى اسمه، ومثل ما يعرض من نسيان
الأُمور الهينة الحفظ التي تهم. وإِنما كان النسيان مغضبا لأَنه يرى أَن
سببه هو التهاون بالشيءِ المنسي. والذين يبتدئون بالإِحسان فلا يكافأون،
قد يغضبون أَيضا على الذين لا يكافئونهم بالواجب. فإِن النقصان من الواجب
إِنما يحمل عليه التهاون. والذين يهزلون في الشيءِ الذي تجِدُّ فيه أَنت
تغضب عليهم. وإِذا كان بعض من تعرفه من الناس يحسن إِلى غيرك ولا يحسن
إِليك، فإِنك تغضب عليه.
فقد تبين من هذا القول من الناس المعدون لأَن يغضبوا ولأَن يغضب عليهم،
وما الأَشياءُ الفاعلة للغضب، وهي الأَشياءُ التي إِذا وجدت للمرءِ أَثبت
بها أَن المرءَ قد غضب. ومن هذه الأَشياء الثلاثة بعينها تؤخذ مسكنات
الغضب أَو فاعلات الغضب. فإِن أَضداد الأَشياء الفاعلة للغضب إِذا أُثبتت
لشخص ما إِما أَن يسكن عنه الغضب وإِما أَن توجب الرضى عنه. وكذلك إِذا
وجدت للمرءِ أَضداد الأَحوال التي يكون بها معداً لأَن يغضب عليه بها، سهل
سكون الغضب عنه أَو وجود الرضى عنه. وكذلك إِذا وجدت للمرءِ أَضداد
الأَحوال التي بها يكون غضوبا سهل قبوله للرضى أَو لسكون الغضب عنه. فإَِن
الغضب له ضدان: أَحدهما عدمه، والآخر ضده وهو الرضى. ولكن أَرسطو في هذا
الموضع مع تعريفه بهذا يأْتي بالأَشياءِ المسكنة للغضب على جهة الارتياض.
القول في المسكنات للغضب
قال: ومن أَجل أَن ضد الغضب هو سكون الغضب، فقد ينبغي أَن ننظر من أَمر سكون الغضب في أَضداد تلك الأَشياءِ الثلاثة التي ذكرناها، أَعني بأَية حال يكون الناس الذين يسهل سكون غضبهم، وبأَية حالة يكون الناس الذين يسهل سكون الغضب عليهم، وأَما الأَشياء المسكنة للغضب.قال: والسكون هو عدم الغضب أَو فتوره. وإِذا كان الغضب إِنما
سببه التهاون الذي يكون بالمشيئة والطوْع، فهو بيّن أَن الذينلا يتهاونون
- وإِن تهاونوا، فبكره، أَو بغير روية - أَو الذين يظنون أَنهم بهذه
الحال، أَنه لا يغضب عليهم؛ وإِن غضب عليهم، فيكون عنهم سكون الغضب سريعا.
وقد يكون سكون الغضب بأَن يفعل بالغاضب آلام ومكاره تنسيه الاحتقار به
الذي كان سبب غضبه على جهة القصد والتعمد لذلك. وهذا إِنما يفعله الدهاة
ذوو الشرور العظيمة. ومما يفعل السكون أَن يفعل المرءُ بنفسه الأَشياء
التي ظنها الغاضب احتقارا به. فإِن هذا يوهم فيه أَنه ليس يرى فيها أَنها
احتقار، إِذ كان أَحد لا يرى أَنه محتقر لنفسه.
قال: ومما يفعل الكون الاعتراف بالذنب أَو أَن يجعل على نفسه أَلا يعود
إِليه وهو المسمى عندنا توبة، أَو أَن ينقلب إِلى ضد الاستهانة وهو
الإِجلال. وإِنما كان الاعتراف مسكنا للغضب لأَنه يوجب العقوبة. ووجوب
العقوبة مما يفتر الاهتمام بما فعل والارتماض له. وذلك بيّن عند مشاهدة
المعاقبات المحسوسة، فإِنا قد نعاقب أَكثر ذلك بشدة وزيادة الذين يجحدون
ويحتجون عن أَنفسهم. فأَما الذين يقرون ويعترفون أَن العقوبة النازلة بهم
عدل، فقد يفتر الغضب عن هؤلاءِ. وأَيضا فإِنه قد تكون علة الجحود للأَمر
الظاهر وقاحة الوجه والصلف. والوَقاح مستهزيء مستهين. فإِن الذين لا
يُستحى منهم ليس لهم قدر، فيشتد الغضب لذلك على الجاحد. وأَيضا فإِن
الإِقرار ذلة واعتراف بالنقيصة، وهذا يتنزل منزلة العقوبة الواقعة بهم.
وأَما الذين لا يعترفون فإِنهم يرون غير خائفين ولا متذللين للغاضب عليهم.
وذلك مما يخيل فيه الاستهانة بالغاضب عليهم.
قال: وقد يدل على أَن الغضب يفتر عن الذين يذلون ويتواضعون ما يظهر من فعل
الكلاب، وذلك أَنه تكف عن الناس الجلوس والمتدين وتنهش المستعجلين. وقد
تأْتي مواضع ليس يظن بالجحود فيها أَنه استهانة بل دعوى الحق، وذلك إِذا
لم يكن الذنب ظاهراً.
قال: ومن الأَصناف الذين لا يغضب عليهم، أَو شأْن الغضب أَن يفتر عنهم،
الصنف من الناس الذين هم طيبو النفوس، سلسو القياد، حسنو الخلق يحتملون،
وهم الذين يسميهم أرسطو مفراحين. والصنف المحتاج أَيضا يقل الغضب عليه
لمكان الرحمة له، إِذ كانت الحاجة النازلة به بمنزلة العقوبة. والصنف من
الناس الذين يستعفون من الخصومات ويتفادون من المنازعات، فإِنه أَيضا يسكن
الغضب عنهم لمكان الذلة والتواضع الموجود فيهم. والذين لا يشتمون أَحدا
ولا يطنزون به ولا يحتقرونه. أَو الذين إِن فعلوا ذلك فعلوه في الأَقل
فليس يغضب عليهم. وإِن غضب، فيسكن الغضب عنهم سريعا.
قال: وبالجملة فينبغي أَن تؤخذ مسكنات الغضب وذلك في الأَكثر من أَضدادها
التي عددت قبل في باب الغضب.
قال: والذين يُهابُون أَو يَستحى منهم لا يُغضب عليهم ما داموا بهذه
الحال، لأَنه لا يمكن أَن يغضب المرءُ على إِنسان ما ويخافه معا في حال
واحدة. والذين فعلوا الاحتقار والاستهانة بالمرءِ في حال غضبهم عليه،
فإِما أَلا يغضب عليهم، وإِما إِن غضب عليهم فيسير، لأَن الغاضب على
إِنسان ما ليس يظن به أَنه يحتقره، ويغضب عليه معا. وذلك أَن الاحتقار ليس
فيه أَذى للمحتقر سواء كانت فيه لذة أَو لم تكن. وأَما الغضب فهو لذة مع
أَذى كما تقدم في حَده. والإِنسان المغضوب عليه فقد يسكن الغضب عنه أَن
يكون يستحي مما فعل.
قال: والأَحوال التي يكون فيها الغضب قبيحا أَو غير جميل، فأَما
أَلا يغضب فيها الإِنسان من الأَشياءِ المغضبة الواردة عليه من خارج،
وإِما إِن غضب فيسكن غضبه سريعا، وذلك كأَفعال الاحتقار التي يؤدب ويعلم
بها الإِنسان مثل انتهار المتعلم، ومثل أَفعال الاحتقار التي يقصد بها
المزح في الحالة التي يكون المقصود منها المزح، أَو التي يقصد بها اللهو
في الحالة أَيضا التي يكون المقصود منها اللهو. والفرق بين المزح واللهو
عند أَرسطو أَن المزاح يقصد به تطييب نفس الممزوح به، لا أَن ينال بذلك
المازح لذة. واللهو يقصد به أَن يلتذ اللاهي لا الملهو به. ولذلك يمزح
الأَخيار ولا يلهون. وكذلك أَيضا أَفعال الاحتقار التي يقصد بها التأْنيب
والموعظة عند الزلات والعوارض الرديئة. ومنها أَيضا سد الخلة بالشيءِ
اليسير المحتقر، فإِن المحتاج لا يغضب منه إِذا كان فيه سد خلته، ولو كان
نزراً محتقراً.
قال: وبالجملة فكل فعل من أَفعال الاحتقار أَو المحتقر إِذا لم يقترن به
أَذى للمحتقر به ولا لذة قبيحة، أَو اقترن به رجاء وأَمل فليس يغضب منه.
فمثال ما لا يقترن به أَذى الاحتقار الذي يؤدب به. ومثال ما لا يقترن به
لذة قبيحة المزاح الذي لا يخرج إِلى الفحش. ومثال ما يقترن به حسن رجاء سد
الخلة.
قال: وإِذا طال الزمان ولم يتكرر من المغضوب عليه فعل يوجب تجدد الغضب،
فقد يسكن طول الزمان الغضب.
قال: ومما يسكن الغضب العظيم الأَخذ بالثأْر إِما أَولا فمن الجاني نفسه
وإِما ثانيا فممن يتصل بالجاني. وربما لم يسكن الغضب أَخذ الثأْر من
الجاني الأَول حتى يأْخذه ممن يتصل به، إِذا لم ير الجاني الأَول كفؤا له،
ورأَى أَن من يتصل به هو كفؤ له. ولذلك ربما ترك الجاني نفسه وأَخذ الثأْر
ممن يتصل به. وقد يسكن الغضب الانتقام من غير الظالم ومن غير من يتصل به
بل ممن اتفق من الناس. وكذلك قد يسكن الغضب نزول الشرور العظيمة بالجانين،
وإِن لم يكن ذلك من قبل المجني عليهم، لأَنهم يرون كأَنهم قد أَدركوا
ثأْرهم.
قال: والذين يعتقدون في أَنفسهم أَنهم ظالمون فليس يغضبون من الأَفعال
الواردة عليهم من المظلومين، لأَنهم يرون أَو تلك الأَفعال هي عدل، والعدل
لا يغضب منه.
قال: ولذلك ما ينبغي أَن يتقدم المعاقِب أَولا فيبين بالقول أَن المعاقَب
ظالم، وحينئذ يعاقب. فإِنه إِذا كان الأَمر كذلك، لم يلحقه أَذى من
المعاقَب.
وقد ينفق في أَفراد من الناس وهم الشرار والعبيد العُتاة أَن يعلموا أَنهم
ظالمون، ولكن مع ذلك يغضبون ويتذمرون، وإِنْ كانت العقوبة التي نالتهم
بعدل، لأَن هؤلاءِ لا يرون أَن ينالهم أَذى.
والذين لا يشعرون بالاحتقار والضيم النازل بهم لا يغضبون أَيضا. وهذا قد
يعرض من قبل الجهل، وقد يعرض من قبل كبر النفس لأَنهم يرون أَن الأَفعال
التي يضامون بها ويحقرون ليس هي مما يوجب لهم تحقيرا. ولذلك قد يختبر كبار
النفوس بأَن يسلب عنهم كثير من أَفعال الفضائل التي تنسب إِليهم ليرى كيف
تأَثرهم عن ذلك، فإِنه كلما كان الفعل المسلوب عنه أَكبر ولم يغضب منه،
كان أَدل على كبر نفسه.
قال: ولموضع هذا لما أَراد فلان أَن يختبر كبر نفس فلان لرجل معروف عندهم
بكبر النفس، قال له إِنك لست معدوداً في فتاحي المدائن، ليعلم هل يغضب من
ذلك أَم لا. وبالجملة فكل من لا يتأَذى بالاحتقار إِما من قبل صغر قدر
المحتقر وإِما من قبل كبر قدر المحتقر به. والمستضام فإِنه لا يغضب، لأَن
الغضب قد قيل في حده إِنه أَذى مع شوق إِلى الانتقام. والهالكون لا يغضب
عليهم لأَنهم قد صاروا إِلى شر أَعظم من الشر المؤمل فيهم.
قال: ولذلك ما استعمل أُوميروش هذا المعنى في تسكين غضب فلان على فلان
لناس مشهورين عندهم بأَن قال في المغضوب عليه: إِنه الآن معانق للأَرض
البكماءِ التي لا يفارقها أَبدا. وإِنما كان الأَمر هكذا لأَن الذي تنزل
به مصيبة الموت يرثى له، إِذ كانت أَعظم المصائب. ولهذا الذي قاله ينبغي
أَن يعتقد أَن الناس الذين لا يكفون عن الأَموات، إِذا لم يكن من يتصل بهم
ممن يغضب عليه أَو ينافس في دنيا، أَنهم من شر الناس.
قال: فقد تبين أَن الذين يريدون أَن يسكنوا الغضب أَو يفتروه أَن من هذه
المواضع ينبغي أَن يأْخذوا المقدمات المسكنة له، أَعني جزئيات هذه المواضع.
والغضب بالجملة يفتر ويسكن عن ستة أَصناف من الناس كما قيل:
أَحدها الصنف المخوفون، والصنف الثاني المستحى منهم، والصنف الثالث
المفراحون من الناس، والرابع الذين يفعلون الاحتقار لا بالاختيار، والخامس
أَن يكون قد نزل بهم من الشر ما هو أَعظم من الذي يتشوقه الغاضب عليهم،
والسادس أَن يكونوا قد بادوا وهلكوا.
وهذا آخر ما قاله في الغضب وضده.
القول في الصداقة والمحبة
قال: فأَما مَنْ الناس الذين يصادِقون ويصادَقون بالطبع وما الأَشياءُ الفاعلة للصداقة فإِنه قد يوقف على ذلك إِذا تقدم أَولا فحُدت الصداقة والمصادقة، فنقول: إِن الصداقة هي أَن يكون الإِنسان يهوى الخير لإِنسان آخر من أَجل ذات ذلك الإِنسان، لا من أَجل ذات نفسه، وأَن تكون له قوة ومَلكة يفعل بها الخير له. والمصادقة هي أَن يكون كل واحد منهما من صاحبه بهذه الحال. وإِذا كان ذلك كذلك، فالصديق بالحقيقة هو الذي يحب ويُحَب معا. وقد يظن أَنه يحتاج هاهنا في الصداقة التامة إِلى شرط ثالث وهو أَن يكون كل واحد منهما مع أَنه يُحب الخير لصاحبه من أَجل ذات صاحبه أَن يعلم كل واحد منهما محبة صاحبه له. وإِذا كان هذا موضوعا لنا في حد الصداقة فبين أَن الصديق هو الذي يستلذ الخير الذي يكون لصديقه، ويشاركه في المؤذيات والمحزنات التي تنزل به ليس من أَجل ذاته لكن من أَجل ذات صديقه. وإِذا كان الصديق بهذه الصفة، فكل واحد من أَصدقائه يفرح به ويسر به. ولذلك كان الناس المشاركون بالطبع في السراءِ والضراءِ محبوبين، وأَما الأَعداءُ فهم بضد هؤلاءِ، أَعني أَنهم تؤذيهم الخيرات الواصلة إِلى أَعدائهم وتلذهم الشرور الواقعة بهم. وإِذا كانت الصداقة يلزمها هذا فبين أَن العلامة التي يوقف منها على أَن المرءَ محب وصديق هي أَن يحزن للشر الواقع بصديقه، وأَن يسر بالخير الواصل إِليه. ومن علامة الصداقة أَيضا المشاركة في الخير والشر. وكذلك من علامتها أَن يكون فعل المرءِ مضادا لفعل العدو في الشيءِ الواحد بعينه إِذا قاس أَحدهما إِلى الآخر، مثل أَن يستعين بإِنسانين فيعينه أَحدهما ويسلمه الآخر؛ فإِن الذي يعينه صديق والذي يسلمه عدو. وإِذ قد تبين أَن الصديق هو الذي يهوى الخير من أَجل ذات صديقه، وأَن هؤلاءِ محبوبون بالطبع، فبين أَن الذين يحسنون إِلى إِنسان ما أَو ناس ما أَو إِلى من هو بسببهم أَنهم محبوبون عند أُولئك الذين أَحسنوا إِليهم، وأَن الإِحسان أَحد فاعلات المحبة. وكذلك الذين يفعلون بآخرين أُموراً عظيمة ذوات كلفة ومشقة بسهولة ونشاط هم أَيضا محبوبون عند الذين يفعلون بهم ذلك، وسواءٌ كان ذلك الأَمر شاقا بإِطلاق أَو كان شاقا في وقت فعله فقط، باشروا ذلك بأَنفسهم أَو لم يباشروا ذلك بأَنفسهم، لكن كانوا هم السبب في إِيصال ذلك الأَمر الجسيم إِليهم.قال: والذين يظن بهم أَنهم يهمون بالإِحسان محبوبون. وصديق
الصديق محبوب وكذلك الذين يحبون المحبوبين محبوبون. وكذلك الذين يحبهم
المحبوبون والذين يعادون ويبغضون مَنْ يبغض المرءَ محبوب أَيضا عنده.
وكذلك الذين يبغضهم المبغضون للمرءِ هم أَيضا محبوبون عنده. وجميع هؤلاءِ،
أَعني المحبوبين، يرون أَنهم أَصدقاءُ، لأَنهم يرون أَن الخيرات التي
لأُولئك هي لهم ولذلك يهوون أَن تكون الخيرات التي لهم هي أَيضا
لأَصدقائهم، كما هي لهم من قبل أَصدقائهم، أَعني الذين كانوا يحسنون
إِليهم ويكرمونهم. ولمكان هذا يكرم الأَسخياء والشجعان، أَعني لمكان ما
يرى الناس أَنه يصل إِليهم من المنفعة بهم. والخيرات التي تصل إِليهم من
الناس هي الكرامة. والفضلاءُ الأَبرار هم الذين يُسْدون إِلى كل أَحد من
الخير بحسب ما يقدرون عليه بحسب حال حال من أَحوالهم وأَقل أَحوالهم أَنهم
لا يكلفون أَحداً شيئا وهؤلاء، كما يقول أَرسطو، إِنما يكونون بهذه الحال
إِذا كانوا لا يعيشون من أَصحابهم، يعني أَنه لا يكون عيشهم من مواساة
أَصحابهم لهم، بل يكون معاشهم من استعمالهم أَنفسهم وكدهم أَبدانهم.
والأَفضل من هؤلاءِ مَنْ كان معاشهم من شيءٍ شريف، مثل المعاش الذين يكون
من الحرب التي تكون على طريق السنة، لا من أُمور سوقية، أَو يكون معاشهم
من الصيد أَو من الرعاية، وبالجملة: يكون معاشهم من وجه لا يحتاجون فيه
لأَهل المدينة من غير أَن يلحقهم بذلك شين. فهذا الصنف من الناس قد يظن
بهم أَكثر من غيرهم أَنهم أَعفاء غير ظلامين سليمة صدورهم. والذين يفوض
إِليهم أَن تفعل بهم الأَفعال التي تفعل بالأَصدقاءِ إِن اختاروا ذلك هم
أَيضا محبوبون. وهؤلاءِ هم الأَخيار ذوو الفضائل. فإِن هؤلاءِ يرون مكتفين
بأَنفسهم وبأَحوالهم عن الأَشياءِ التي من خارج. ولذلك متى أَراد إِنسان
أَن يفعل بهم فعل الصديق بصديقه من إِيصال الخير إِليه خيّرهم في ذلك.
والسعداء المنجحون إِما في كل الخيرات، أَعني النفسانية والبدنية والتي من
خارج، وإِما في الخيرات التي هي منها فضائل فقط، وإِما في الأَشياءِ التي
يتعجب من نيلها إِما بإِطلاق وإِما بالإِضافة لأُولئك الذين نالوها،
محبوبون أَيضا.
قال: والطيبو النفوس والذين عشرتهم وملازمتهم النهار كله لمكان الالتذاذ
بهم من غير أَن يمل حديثهم فإِن جميع هؤلاءِ محبوبون لأَن أَخلاقهم جميلة
سهلة وليسوا موبخين على الخطإِ والإِساءة ولا يشغبون ولا يتعسرون ولا
يحرشون ولا يستثيرون لفعل الشر إِذا أُثيروا ولذلك كان جميع من اجتمعت فيه
هذه الصفات المذمومة صخابين، أَعني المستعلين على الإِنسان برفع الصوت عند
المخاطبة وبالحرد، فالصخابون هم أَضداد أُولئك. وكذلك الجفاة من الناس
القادرون على ضربهم بقوة أَبدانهم أَو الصابرون على ما ينالهم من المكروه
أَو الذين جمعوا الأَمرين مسارعون إِلى الصخب وإِلى عذل أَقاربهم وجيرانهم
وأَصدقائهم. وذلك إِما - إِذا أَمكنهم - أَن يعذلوهم، وإِما إِذا أَوهموا
أَن عذلهم هو من جهة الشفقة.
قال: والذين يمدحون قد يحبون الممدوحين لأَنهم يتوقعون منهم أَن
يشاركوهم في الخيرات التي عندهم لمكان مدحهم إِياهم. وأَما المادحون
فمحبوبون عند الممدوحين، وإِن كان المدح بأَشياء لا يأْمن الممدوح أَلا
تكون فيه وأَن تكون كذبا. والذين ينظفون لباسهم وأَزياءهم طول أَعمارهم
محبوبون، لأَنهم يرون أَنهم مُكرمون للناس بتلك النظافة وغير مؤذين لهم
بالمناظر القبيحة. والذين لا يعيرون بالذنوب ولا يعاتبون على الجنايات،
فإِن الذين يفعلون ذلك موبخون، والموبخون مبغضون؛ وأَعني بالذنوب
الإِساءات التي تكون بين الله وبيْن العبد، وبالجنايات الإِساءات التي
تكون بين إِنسان وإِنسان. والذين لا يصرون على الضغن ولا يقيمُون على
العذل واللجاج، لكنهم يرضون سريعا ويزول غضبهم، محبوبون، وذلك أَنه يظن
بهم أَنه كما أَنهم بهذه الحال للناس، كذلك هم لأَصدقائهم، بل هم أَحرى
بذلك. والذين لا ينطقون بالشر ولا يعرفون شرور أَقاربهم وجيرانهم وذوي
معارفهم لأَنهم أَخيار ليس عندهم شر محبوبون. والذين لا يشغبون على الذين
يغضبون عليهم أَو يجدون عليهم في أَنفسهم ويحقدون محبوبون، فإِن الذين هم
بخلاف ذلك صخابون. والذين يتعجبون من غيرهم بالنوع الذي يتعجبون به من
أَنفسهم محبوبون، لأَنهم ليس يظن بهم أَنهم يراؤون بذلك التعجب، إِذ كان
ليس أَحد يتعجب من نفسه إِلا بشيءٍ هو عنده بالحقيقة فضيلة ومتعجب منه.
والذين يفرحون بالمرءِ وبما عنده محبون عند الذي يفرح به، ولا سيما إِذا
كان الفرح عن انفعال بيّن، لأَنه يظن به أَنه أَحرى أَن يكون ذلك الفرح
ثابتا وأَنه لا يرائي بذلك الفرح. والمكرِمون محبوبون عند الذين يكرمونهم.
والمكرَمون محبوبون عند المكرِمين لهم. والذين يحب المرءُ أَن يحسدوه
حسداً لا يَبلغ بهم الاغتيال له والسعاية عليه محبوبون، لأَنه ليس يهوى
المرءُ هذا من أَحد إِلا وهو يهوى أَن يقف ذلك المرءُ على فضائله. وإِنما
يهوى ذلك منه إِذا كان عنده أَهلا لذلك. فلذلك من كان بهذه الصفة عندك
فإِما أَن تكون صديقه أَو تهوى أَن تكون صديقه، لأَنه إِذا كنت صديقه كان
أَحرى أَن يقف على الفضائل التي فيك. والذين يفعلون الخيرات محبوبون عند
المفعول بهم الخير إِن لم يتبعوا الخير بشر هو أَعظم وأَفظع، مثل الامتنان
الكثير والاستخدام الشاق. والذين يحبون الأَقارب والأَباعد الأَحياء منهم
والأَموات، أَعني ممن هو قريب أَو صميم أَو من المعارف. فإِن الأَموات لا
يحبون إِلا بشرطين: أَحدهما أَن يكون موتهم قريب العَهْد، والثاني أَن
يكونوا أَقرباء أَو معروفين. فكل أَحد يحبهم لمكان صدق محبتهم، لأَنه إِذا
أَحب الأَجنبي فهو أَحرى أَن يحب القريب. وإِذا أَحب الميت فهو أَحرى أَن
يحب الحي. ولذلك كان بالجملة الذين يحبون أَصدقاءهم جدا جدا ولا يخذلونهم
محبوبون، فإِن هؤلاءِ الصنف من الناس هم خيار، والإِنسان يحب الخيار الذين
ليسوا بأَصدقاء، فكيف الخيار الأَصدقاء. والذين ليس ودهم رياء ولا تصنعا
مودودون. والذين يخبرهم المرء بمساوئه ولا يستحي عندهم من ذكرها هم
أَصدقاء له، لأَن الصديق هو الذي لا يستحي عنده من ترك الأَشياءِ التي
يفعلها المرءُ لمكان الحمد والمرءُ القليل الحياءِ يود المرء القليل
الحياءِ، لأَنه لا يخافه ويثق به. وقد يحب المرءُ المرءَ الذي لا يخافه
ويثق به ويأْمنه؛ لأَنه ليس يحب أَحد الذي يخافه.
قال: فأَما أَنواع أَفعال الصداقة فهي الصحبة والأنس والوصلة وما أَشبه
ذلك النحو مما يفعله الأَصدقاءُ بعضهم ببعض. وأَما الفاعلات للصداقة
فالأَيادي والمنن، وأَن يفعل المرءُ بالمرء الخير حين لا يحتاج إِليه،
أَعني إِلى المرءِ. وإِذا فعل الخير لم يخبر بذلك، وأَن يبين أَنه إِنما
فعل ذلك لمكان المفعول به لا لمكان شيء آخر.
فهذا جملة ما قاله في المحبة.
قال: وأَما العداوة والبغضاءُ فقد ينبغي أَن تؤخذ فيها هذه الأَشياء
الثلاثة من الأُمور المضادة لهذه وهي معلومة بعلم هذه التي ذكرناها. وأَما
فاعلات العداوة فهي فعل ما يغيظ الإِنسان، والعبث، والنميمة؛ وأَعني
بالعبث الازدراء بالجملة، وأَعني بالنميمة السعاية الخبيثة بين نفسين.
والفرق بين الغضب والعداوة أَن الغضب يكون بالأَشياءِ التي تفعل
بالغاضب أَو بمن هو من سببه؛ والبغضة والعداوة فقد تكون وإِن لم يفعل
المبغض بالمبغض له شيئا. فإِنا قد نبغض ذوي النقائص، وإِن لم يجنوا علينا
شيئا. وبالجملة إِذا ظننا بالمرءِ ما يستحق البغضة، فنحن نبغضه أَبدا.
وفرق آخر: وهو أَن الغضب إِنما يكون على الأَشخاص مثل زيد وعمرو أَو
أَقوام محصورين بالعدد؛ وأَما البغضة والعداوة فإِنها تكون للجنس، فإِنا
نبغض البربر ويبغضوننا. وكذلك البغضة قد تكون للصنف فإِنا نبغض السارق
والنموم، وقد يبغضه الناس أَجمعون. وفرق ثالث: وهو أَن الغضب قد يسكن بطول
الزمان من غير أَن يفعل المغضوب عليه بالغاضب ما يزيل الغضب عنه؛ والعداوة
ليس تسكن بطول الزمان، ما لم يفعل المعادَى بالمعادِى ما يوجب مودته.
وأَيضا فإِن الغضب إِنما هو تشوق إِلى شر محدود أَن ينزل بالمغضوب عليه؛
وأَما البغضة فإِنها تشوق إِلى أَن ينزل بالمبغض شر غير محدود، أَعني أَنه
كلما وقع به شر تشوق العدو إِلى أَن يقع به شر أَكثر. وذلك أَن الذي يغضب
إِنما يهوى أَن ينزل بالمغضوب عليه شر محدود يشفى به صدره. وأَما العدو
فإِنه ليس يهوى هذا، بل شراً غير محدود، أَعني شرا أَكثر مما نزل به.
فالبغضة تخالف الغضب بهذه الفصول. وأَيضا فإِن المؤذيات مبغضات،
والأَشياءُ التي هي أَكثر أَذية هي مبغضات أَكثر، مثل الجور والجهالة.
وأَيضا فإِن الغاضب يجد حزنا مع لذة كما قيل؛ وأَما المبغض فليس يجد لذة.
وأَيضا فإِن الغضب قد يزول بأَيسر شيء يفعله الإِنسان، أَعني بأَشياء
كثيرة؛ وأَما البغضة فليس تزول بذلك. وأَيضا فإِن الغاضب إِنما يهوى أَن
ينزل بالمغضوب عليه مكروه ما فقط. مع أَلا ينعدم من الوجود؛ وأَما المبغض
فإِنه يهوى أَن ينعدم المبغض من العالم أَصلا.
قال: وهو معلوم أَنه من قبل هذه الأَشياء التي ذكرناها قد يمكننا أَن نثبت
بالقول انهم أَعداء أَو أَصدقاء أَو أَن نجعلهم كذلك إِن لم يكونوا كذلك،
أَعني إِما أَعداء وإِما أَصدقاء. وكذلك يمكننا بمعرفة هذه الأَشياء
بعينها أَن ننقض على القائلين دعواهم في المحبة والصداقة، أَعني أَن فلانا
عدو وأَن فلانا صديق إِذا دفعنا ذلك، وذلك إِنما يكون، كما قلنا، بمعرفة
ما هي الصداقة والعداوة والغضب، وبمعرفة هذه الأَشياء الثلاثة من كل واحد
منها، أَعني الفاعلات لها، والناس المعدين للفعل بها والانفعال عنها. وقد
ينتفع بمعرفة تثبيت العداوة والغضب في تثبيت الجور، لأَن أَحد الأَسباب
التي من قبلها يجور الجائر هي البغضة والغضب، مثل أَن يثبت في زيد أَنه
جار علينا من قبل أَن بيننا وبينه عداوة.
فهذا آخر ما قاله في الصداقة والعداوة.
القول في الخوف
قال: فأَما معرفة ممن يكون الخوف ومماذا يكون، أَعني الفاعلات له، ومَنْ الذين يخافون، فنحن نبين ذلك هاهنا، بعد أَن نحد الخوف ما هو، كما فعلنا في الأَبواب المتقدمة.فليكن الخوف حزنا أَو اختلاطا من تخيل شر يتوقع أَن يفسد أَو يؤذى، وأَعني بالحزن الغم والأَذى الذي يلحق النفس، وبالاختلاط اختلال الروية، وبالفساد الهلاك، وبالأَذية ما دون الهلاك. وإِنما اشترط في الشر المخوف أَن يكون مهلكا أَو مؤذيا، لأَن إِمكان وجود النقائص في الإِنسان هي شرور متوقعة، ولكن ليس يخافها الإِنسان، مثل أَن يكون ظلوما أَو كسلان؛ وليس أَن يكون الفساد أَو الأَذى المخوف يسيراً، بل وأَن يكون عظيما. فإِن اليسير لا يخافه أَحد. وأَيضا فليس يخاف من هذه ما كان متوقعا حدوثه في الزمان المستقبل البعيد، بل ما كان متوقعا في الزمان المستقبل القريب. فإِن الشر المتوقع في الزمان المستقبل البعيد ليس يخافه أَحد، بدليل أَن كل أَحد يعلم أَنه يموت لا محالة، ولكن لأَنه ليس يعلم أَنه قريب، فهو لا يخاف الموت. وإِذا كان حد الخوف هو هذا، فبين من ذلك أَن المخوفين هم الذين يظن بهم أَن لهم قوة عظيمة على الإِفساد، أَعني الإِهلاك، أَو على إِدخال نوع من الضرر يؤدي إِلى حزن أَو أَذى عظيم إِما جسدي مثل الأَسقام وإِما نفساني مثل الذل والصغار. وكوْن مَن هذه صفته مخوفا معروف بنفسه. فإِن المخوف إِنما هو الشر الذي يظن قريبا. ولذلك كان الخطر أَو الهول الشديد إِنما هو اقتراب الأَمر المخوف وهو الذي يفعل العداوة والغضب في الخائف ويحركه إِلى دفع الشيء المخوف ومقاومته. وإِذا كان المرء يهوى الشر وله قوة عليه، فبين أَن شره قريب من الفعل، فهو ضرورة مخوف. والحَال في المخوف كالحال في الظلوم، أَعني أَن الظلوم إِنما يكون ظلوما متوقع الظلم بهذين المعنيين، أَعني بالقوة على الظلم ويهوى الظلم؛ لأَن الظلوم إِنما يظلم بالفعل، إِذ كانت له قوة على الظلم وإِرادة لفعل الظلم. فالظلوم لا محالة أَبدا مريد لفعل الظلم، وهواه متقدم لفعله. وإِنما يفعل الظلم في الوقت الذي تكون له القوة على فعله. فإِذن باجتماع هذين له، يكون ظلمه قريبا. وكذلك المخوف أَيضا إِنما يكون لمن اجتمع له هذان، أَعني القوة والإِرادة. ولذلك لا يخاف أَحد شر الضعفاءِ، وإِن كانوا مريدين للشر؛ كما لا يخاف الأَقوياء، إِذا لم يكونوا مريدين للشر. وكثير من الناس إِنما يمنعهم من الشر ضعفهم أَو الخوف من شر مهول يطرأ عليهم. وما كان من الشر المتوقع قد حدث بإِنسان آخر فهو يخاف أَكثر. والذين يعرفون بأَنهم يفعلون الشرور الشديدة الفظيعة الناسُ لهم خائفون بالطبع. والذين يقدرون على العقوبات مخوفون إِلا أَن يعرفوا بالصفح والعفو، وبالجملة الذين يقدرون على الضرر مخوفون أَبداً عند الذين يكونون ذلك النوع من الضرر ممكنا لهم. مثال ذلك أَن السراق مخوفون عند ذوي الأَموال، لا عند من لا مال له. وإِنما كان ذلك كذلك لأَن الظلم يكون في الناس أَكثر ذلك مع القوة، أَعني حيث توجد القوة يوجد الظلم. والذين يقع بهم الظلم مراراً، ويظنون أَنهم سيظلمون، هم خائفون أَبداً، مثل أَهل الذمة. والذين يلقون أَبدا خلاف ما يؤملونه هم خائفون. والذين في طباعهم الظلم، إِذا كانت لهم قوة، فهم مخوفون. وكل ما لا يمكن أَن يشترك فيه اثنان فهو مخوف خطر، مثل الرياسة. وذوو الرياسات والسلطان هم أَبداً مخوفون ولا سيما إِذا كانوا يهوون الإِضرار بمن يفضلهم في الرأي وفي غير ذلك من الفضائل. والناس الذين يخافونهم أَفاضلهم وذوو الكمالات فيهم هم مخوفون، سواء كانوا ممن لم يزل بهذه الصفة أَو حصلت له هذه الصفة حين كبر وعظم قدره. وأَصدقاءُ المظلومين مخوفون عند الظالمين لهم. وكذلك أَصدقاءُ الأَعداءِ أَيضا مخوفون. كما أَن العدو مخوف. وليس السريع الغضب من الناس ذوى الأُنس والانبساط مخوفين عند الغضب والحقد، لأَن هؤلاءِ ينحل غضبهم سريعا. وإِنما المخوفون ذوو الأَناة في الغضب والحقد وذوو الإِزراءِ بالناس الدهاة الذين لا يظهرون ما يريدونه من الشر هل هو بالقرب أَو بالبعد وهم أَضداد ذوى الأُنس، وذلك أَن ذوى الأُنس يظن بهم أَنهم لا يرون أَحداً دونهم، وذوو الإِزراءِ يرون الناس دون أَقدارهم.
قال: وجميع هذه الأَشياءِ المخوفة تكون مخوفة أَكثر إِذا كان
الفساد الواقع عن ذلك الشيء المخوف مما لا يمكن أَن يتلافى فساده، لكن
يكون إِفساده إِفساداً بالكلية، ولا سيما إِذا كان المفسد لا يمكن أَن
يكافأَ على إِفساده بأَن تنزل به الأَضداد التي هي مكروهة عنده. والذين لا
يجد الإِنسان عليهم ناصراً، فخوفه منهم أَشد. وبالجملة: فالشرور المخوفة
هي الشرور التي تحدث بآخرين، إِذا كان حدوثها بأُولئك الآخرين مما يخيل
وقوعها بالمرءِ، وذلك لموضع التشابه الذي بينه وبين أُولئك الآخرين الذين
نزل بهم الشر. مثال ذلك أَن الشاب إِنما يجزع من الموت إِذا رآه قد نزل
بشاب آخر مثله، لا إِذا رآه قد نزل بشيخ أَو بكهل.
قال: وهذا الذي ذكرنا من جزئيات الأُمور المخوفة والأُمور التي هي أَشد
مخافة وأَعظم هو قريب من أَن يكون يأْتى على جميعها إِلا اليسير الذي يمكن
الإِنسان أَن يأْتى به من تلقائه.
قال: فأَما أَي الأَحوال هي أَحوال الناس التي إِذا وجدت لهم، كانوا
خائفين فنحن الآن مخبرون عنها، فنقول: إِن الخوف هو توقع المرء أَن يمسه
شر مفسد. وهذا معلوم بنفسه. فإِنه ليس أَحد يظن أَنه لا يناله شر فيخاف
أَصلا، ولا إِن ظن بالشرور أَنها لا تناله يخاف أَصلا منها. ولا يخاف
أَصلا من الناس الذين يظن بهم أَنه لا يناله منهم شر أَصلا. ولا يخاف
أَيضا في الوقت الذي لا يظن أَنه يلحقه فيه شر. وإِذا كان ذلك كذلك،
فالخوف ضرورةً إِنما يكون للذين يظنون أَنهم تنالهم شرور، ومن الشرور التي
يظنون أَنها تنالهم، وعند الناس الذين يظنون أَنهم ينالونهم بذلك، وفي
الوقت الذي يظنون لحوق الشر لهم وتأْثيره فيهم. وإِذا كان الخائفون هم
هؤلاءِ بالجملة، فمن البيّن أَن الذين يظنون أَنهم لا ينالهم شر هم
المصححو الأَبدان، الحسنة أَحوالهم جدا من قبل الأَشياءِ التي من خارج.
والذين يظنون أَيضا بأَنفسهم أَنهم بهاتين الحالتين وإِن لم يكونوا كذلك،
أَعني صحة البدن وموافقة الأَشياءِ التي من خارج وحسن أَحوالهم بها.
قال: ولذلك ما يوجد هذا الصنف من الناس شتامين جائرين متهورين. وسبب هذا
الظن يكون إِما في الصحة فمن الشباب والشدة، وذلك أَن الشاب والشديد يظن
بنفسه أَنه مصحح، وإِن لم يكن كذلك؛ وإِما في حسن الحال من قبل الأَشياءِ
التي من خارج، فيعرضُ هذا الظن من أَمرين أَيضا: من العدة ومن كثرة
الأَصحاب. وأَضداد هؤلاءِ هم الذين قد أَشعروا أَنفسهم أَنهم يلقون كل
بلاء، فهم ضعفاء عند الشرور المتوقعة كضعف الذين نزل بهم الشر بالفعل،
ولكن على حال؛ فهؤلاءِ يوجد لهم رجاء في الخلاص، فهم يسعون في حصوله. ومن
العلامة الدالة على ذلك أَنهم يحتاجون عند الخوف إِلى المشاورة. وليس أَحد
يستشير فيما لا يخاف، ولا فيما يخاف ولا يرجو الخلوص منه. ولذلك حَدَّ
الخوف الذي يكف به الخائف عن الفعل الذي قصد به كفه عنه هو الخوف الذي
يقترن به رجاءُ الخلوص من ذلك الشر المخوف، وهو الخوف الذي ينتفع به في
هذه الصناعة، أَعني الذي ينبغي للخطيب أَن يمكنه في نفس الذي يريد أَن
يخيفه، أَعني الحاكم أَو السامع. وذلك إِذا أَثبت عندهم أَنهم ممن ينالهم
الشر أَو تصيبهم المصائب من خصمه، مثل أَن يقول لهم: إِن آخرين قد لقوا
ذلك منه من نظرائهم وأَشباههم، وإِنه كثيرا ما تلقى الشرور من الأَشياءِ
التي لا يظن بها أَنها شرور، أَو من الشرور التي يظن بها الإِنسان أَنها
لا تناله، أَو من الناس الذين لا يظن بهم ذلك، أَو في الوقت الذي لا يظن
ذلك فيه، وما أَشبه هذا من الأَقاويل.
فقد تبين من هذا القول ما هو الخوف والأُمور الفاعلة له والناس المستعدون
لهذا الانفعال.
القول في الشجاعة
قال: وقد ينبغي أَيضا أَن نخبر ما هي الشجاعة وما الأَشياءُ الفاعلة لها وأَي الأَحوال التي إِذا وجدت في الناس كانوا بها مستعدين لقبول هذا الانفعال، أَعني شجعانا.قال: والشجاعة والأَمن هما ضد الخوف، وهما يكونان مع تخيل أَو
توهم لرجاءِ الخلاص الذي كأَنه بالقرب، وتوهم المخوفات إِما مفقودة أَلبتة
وإِما بعيدة الوقوع. وتوهم الأُمور المشجعة أَنها منه بالقرب مما يشجع.
وأَعني بالمشجعات العدة التي تلقى بها المخوفات الواردة. ثم أَن يتوهم
أَيضا الردع والتنكير على الذي يخافه في الشيءِ الذي يخافه فيه مما يشجع.
وكذلك أَن يتوهم أَن له أَعوانا كثيرة وقوما عظاما يمنعون أَن يُنال بشر.
ومما يشجع الإِنسان ويؤمنه أَن يكون لا ظالما فيخاف المكافأَة على الظلم،
ولا مظلوما فيخاف تكرر الظلم عليه. ومما يؤمنك من الإِنسان أَو من ناس
بأَعيانهم أَلا يكون بينك وبينه نزاع ولا محاماة في شيء ألبتة وسواء ظن بك
أَن لك قوة على المنازعة أَو ليس لك قوة. ومما يؤمن من الإِنسان الصداقة
والإِحسان المتقدم عليه في الفعل أَو الانفعال، أَعني مثل إِعطائه المال
أَو الرحمة عليه. ومما يؤمن من الإِنسان الذي يخاف منه أَن يكون ذلك
الإِنسان يفعل أَفعال أَهل الفضل أَو أَهل الشرف ويحب أَن يذكر بها، أَو
يفعل أَفعال الصنفين جميعا.
قال: فأَما الأَحوال التي إِذا كانت في الناس كانوا بها شجعاء فأَحدها أَن
يكونوا يظنون أَنهم سيتلافون ويصلحون الشرور الواقعة بهم عند الإِقدام على
ذلك الشيء الذي يخافون من فعله وقوع الشر بهم وأَنهم لا يأَلمون منه أَو
لا يهلكون، أَعني من ذلك الشر الواقع بهم. ومنها أَن يكونوا قد أَشفوا
مراراً كثيرة على الشر العظيم وتخلصوا منه، فإِن هذا مما يشجعهم على الشر
المخوف.
قال: وقد يوجد الناس غير خائفين من الشرور المتوقعة ولا مكترثين بها على
جهتين: إِحداهما أَن يكونوا لم يجربوا ذلك الشيء المخوف، أَعني أَن يكونوا
غير عالمين به. والجهة الثانية: أَن يكونوا مجربين له عالمين به، وذلك
بيّن مما يعرض عند ارتجاج البحر وهوله للراكبين له. فإِن الذين لم يجربوا
أَهوال البحر يوجدون شجعانا فيه لجهلهم بعواقبه، والذين لهم تجربة به
يوجدون شجعانا أَيضا عليه لما اطرد لهم من السلامة فيه. ومما يؤمن من الشر
المخوف أَن يكون غير مخوف عند شبيهه الإِنسان ونظيره، أَو عند من هو دونه،
وإِن كان قد يظن أَنه قد يتخطى الشر الدون ويعتمد الأَرفع، ولذلك قيل:
إِن الرياح إِذا ما أَعصفت قصفت ... عيدان نجد ولم يعبأن بالرَتَم.
لكن المطرد هو الأَول. والذين يظنون أَنهم أَفضل من الرؤساءِ المتسلطين
عليهم فليس يخافون منهم. وكذلك الذين هم بالحقيقة أَفضل والذين يساوونهم
في الفضل ليسوا بخائفين أَيضا لهم. وكذلك الذين يظنون أَنهم يفضلونهم في
الأَشياءِ التي بها صح لهم التسلط والرياسة، مثل كثرة المال وشدة البدن
ونصرة الإِخوان وأَهل البلد وعدة الحرب إِما كلها وإِما النفيسة الخطيرة
منها عند تلك الأُمة. فإِن ذلك يختلف. ومما يشجع ويؤمن أَلا يوجد المرءُ
ظالما لأَحد إِلا لعدوه ظلما يخيف به عدوه فقط. وبالجملة: فالصنف من الناس
الذين يكونون على حال جميلة فيما بينهم وبين الله آمنون. وكذلك الذين
يكونون على حال جميلة فيما بينهم وبين الناس. وكذلك من كان عند الناس بهذه
الحال ربما يتوسم فيه من العلامات الدالة على حسن الحال عند المعاملة.
والذين تكون أَحوالهم جميلة عند أَصحاب الأَلسنة، أَعني المتسلطين
بأَلسنتهم، كالخطباءِ والشعراءِ، وعند العقلاءِ فهم أَيضا غير خائفين،
لأَنهم إِذا كانوا آمنين عند هؤلاءِ، فأَحرى أَن يكونوا آمنين عند غيرهم
قال: والغضب أَيضا مما يشجع. ومما يشجع الإِنسان ويبعث غضبه أَن يكون
مظلوما لا ظالما. والمظلوم إِنما يشجع لمكان الغضب، ولما يعتقد من أَن
الله تعالى ناصرٌ للمظلومين. ومما يشجع على فعل الشيء أَن يظن الإِنسان
أَنه لا يلقى عليه شرا، وإِن لقي، أَنه يقاومه ويتلافى إِفساده.
قال: فأَما المشجعات والمخوفات فقد قيل فيها بالكفاية.
القول في الحياءِ والخجل
قال: فأَما الأَشياء هي التي منها يستحى أَوْ لا يستحى، وعند من
يكون الحياءِ من الناس وأَي حالة فيها هي الحالة التي إِذا كانت في
الإِنسان عرض له هذا الانفعال، فذلك يعلم مما نقوله. فليكن الخزي أَو
الاستحياءِ حزنا أَو اختلاطا يعرض عن وقوع الشرور التي تصير المرءَ غير
محمود، إِما في الحال الحاضرة وإِما فيما سلف وإِما فيما يستقبل.
وأَما الوقاحة فاستهانة وقلة أَلم واكتراث بحدوث هذه بأَعينها، أَعني التي
يكون منها الحياءُ.
وإِذا كان هذا هو حد الاستحياء، فبين أَنه إِنما يستحي المرءُ من هذا
النحو، أَعني مما كان من الشرور يظن قبيحا مستبشعا إِذا ظهر عليه أَو على
من يعنى به. وكلما كان من هذا النحو فهو إِما من فعل الشرارة، وإِما من
فعل الرداءة. وأَعني بفعل الشرارة ما يلحق الغير منه مضرة، مثل جحد
الوديعة وركوب الظلم؛ وأَعني بفعل الرداءة النقائص التي لا يلحق الغير
منها في الأَكثر مضرة مثل إِلقاء السلاح والفرار جبنا وخوفا.
قال: ومن الشرور القبيحة التي يستحي منها معاشرة الذين لا ينبغي أَن
يعاشروا، وحيث لا ينبغي أَن يعاشروا. والذين لا ينبغي أَن يعاشروا هم ذوو
الشرارات وذوو الأَخلاق الدنيئة. ومن الشنيع أَيضا الذي يستحي منه
الأَكتساب من الأُمور الحقيرة أَو المستقبحة أَو من الضعفاءِ كالذي يرزأ
من المساكين أَو من الأَموات.
قال: ومن هذا يقال في المثل: ولو من الميت أَكفانه. وهذا كله من قبح
المكسب واللؤم.
ومن الخلق التي يُستحي منها أَن يكون الإِنسان موسرا ولا ينتفع من ماله
بشيء. وإِن انتفع فنفع يسير. ومن ذلك يَسئَل المقلين ويحتاج منهم وأَن
يتسلف أَيضا حيث لا يصلح به وأَن يكون إِذا وعد إِنسانا بشيء فتقاضاه ذلك
الشيءَ سأَله هو أَيضا حاجة ليدفعه بذلك عن تقاضي ما وعده. وعكس هذا،أَعني
إِذا سُئل شيئا ما تقاضى هو السائل ما كان قد وعده به ليدفع عن نفسه
السؤال. ومما يستحي منه أَن يمدح الإِنسان المرءَ عندما يرى ذلك الإِنسان
مقتدرا على قضاءِ الحوائج ولا يمدحه في غير ذلك الوقت، بل إِذا خاب رجاؤه
ربما قلب في ذمه.
قال: ومما يُستحي منه التملق وهو قريب من أَن يكون مدحا، وذلك مثل أَن
يمدح المرء بأَكثر مما فيه، أَو يخرج المساوئ والنقائص في صور الفضائل،
أَو يجد إِنسان وجعاُ أَو مصيبة فيظهر أَنه أَشد تأَلما منه وأَشد حزنا،
وما أَشبه ذلك مما هو من هذا النحو، أَعني من علامات التملق. ومما يُستحى
منه قلة الصبر عند الوجع أَو الشدة، مثل ما يعرض للشيوخ الذين يتخيلون أَن
بهم من ضعف الشيخوخة أَكثر مما بهم، ومثل ما يعرض للمترفين وذوي السلطان
الذين يجزعون لمكان سلطانهم من أَدنى شيء يصيبهم، إِذ كانوا يرون أَنه لا
ينالهم مكروه. وكذلك مَن سوى هؤلاءِ ممن هو أَضعف منهم، أَعني ممن يخيل
إِليه في الضعف اليسير الذي به أَن به ضعفا عظيما. فإِن هذه الأَحوال كلها
مذمومة وهي من علامات الخور والمهانة. ومما يستحي منه أَن يكون المرء يعير
ويلوم من سواه بحسن الانفعال أَو الفعل، مثل أَن يلومه على فعل السخاءِ
أَو عن المحاماة عن أَصدقائه أَو على الإِشفاق والرحمة. ومن ذلك أَن يمدح
المرءُ نفسه أَو أَن يعد منها بأَشياء جميلة، أَو ينسب إِلى نفسه أَفعال
غيره. فإِن هذه كلها من علامات المخرقة.
قال: ومن هذه الأَخلاق المذمومة التي ذكرناها يستدل على ما لم يذكر منها
لأَن لكل واحد من الشرور ومساوئ الأَخلاق أَفعالا وعلامات تدل عليه.
قال: ومن المستقبح من الإِنسان أَن تكون أَفعاله في صورة ما هو
قبيح وإِن لم تكن قبيحة، مثل أَن يكون الإِنسان من أَهل بيت أَو من أَهل
مدينة هم أَهل قبائح، فإِن الإِنسان قد يلحقه من قبل هؤلاءِ مخاز وإِن لم
تكن له أَشياء يخزى منها في نفسه. ومما يعير به الإِنسان أَن يكون أَشباهه
من الناس يفعلون أَفعالا جميلة ولا يشركهم هو فيها، أَعني في كلها أَو
أَكثرها.وأَعني بالأَشباه المتساوين في الجنس والذين هم من مدينة
واحدة،والأَتراب، أَعني ذوي الأَسنان المتقاربة، والذين تجمعهم حالة
واحدة: إِما حلف، وإِما صداقة، وإِما غاية واحدة يقصدونها؛ وبالجملة جميع
الذين يستوون في شيءٍ واحد، مثل أَن يكونوا أَهل صناعة واحدة أَو عمل
واحد. وإِنما كان ذلك كذلك، لأَن مباينة المرء من يساويه ومخالفته له قبيح
مستنكر حتى في العقوبات النازلة بهم والشرور التي تنالهم، وذلك أَن النكبة
التي تنال مثلا أَهل المدينة، والغموم التي تنال الأَصدقاء، متى لم
يشاركهم الإِنسان فيها، كان قبيحا به، وكذلك جميع الخيرات والشرور الباقية.
قال: وجميع أَفعال المخازي التي ذكرناها إِنما تظهر في هؤلاء الأَصناف من
الناس الذين عددنا، وذلك في الأَكثر مثل الجشعين والخوارين وما أَشبههم.
وهذه الأَفعال التي ذكرناها هي أَفعال تصدر عن الشرارة وقبح الأَخلاق، ولا
سيما إِذا كان الإِنسان من تلقاءِ نفسه هو السبب فيما كان من هذه الأَفعال
أَو يتوقع أَن يكون.
قال: وأَما المخازي التي تلحق الإِنسان مما يناله من غيره أَو يذعن له أَو
تتصل به بأَي وجه اتصل، فكل ما كان مما يؤدي به إِلى أَن يهوى بها عند
الناس وأَن يعير به، وذلك مثل جميع الهئات البدنة القبيحة، مثل أَن تحلق
لحيته، أَو يتزيا الرجل بزي المرأَة، ومثل جميع الفواحش التي تفعل
بالنساءِ والصبيان. ومن هذا الفضيحة والهوان، وأَعني بالفضيحة الاشتهار
عند الناس بأَمر قبيح، وبالهوان مثل أَن يزدرى به فيظلم أَو يكون وحيدا لا
ناصر له. ومن هذه الأَشياء القبيحة التي يركبها الإِنسان ويصبرعليها من
غيره لمكان الطمع والجشع، مثل الذين لا يبالون بأَي وجه اكتسبوا المال من
أَوجه خسة المكسب. وسواء كانت الأَشياءُ لاحقة للإِنسان باختيار منه أَو
بغير اختيار، مثل فعل الفواحش بنساءِ الإِنسان أَو ولده، فإِنه يلحقه بذلك
العار، سواء كان باختياره أَو بغير اختياره. ومما يُستحى منه الا يأَخذ
الإِنسان بثأره.
قال: فهذه التي ذكرناها وما أَشبهها هي الأَحوال التي إِذا كانت في الناس
استحيوا وخزوا منها، وهي الأَشياءُ التي تفعل الخزي والاستحياء.
لأَن الخزي والاستحياء إِنما يعرض للمرءِ إِذا تخيل الأَمر الذي يحمد عليه
أَو الأَمر المحمود وأَنه قد عدمه. ومن أَجل أَن الخزي إِنما يكون من قبل
تخيل عدم الحمد، وكان عدم الحمد إِنما يكترث منه إِذا كان من قبل الفضلاءِ
من الناس، فبين أَنه ليس يُستحى من كل أَحد من الناس. وإِذا كان الأَمر
كذلك، فإِنما يستحي المرءُ بالجملة من القوم الذين يأْلم بفقد مديحهم.
وأَحد هؤلاءِ هم الصنف من الناس الذين يتعجبون منك ويرون لك فضلا كبيرا؛
وكذلك الصنف من الناس الذين تتعجب أَنت منهم تستحي منهم؛ والذين تحب أَن
يكروموك تستحي أَيضا منهم.
قال: والذين لا يستخف بحمدهم فقد يحب أَن يكونوا متعجبا منهم. وإِنما
يتعجب من كل من كان له خيرٌ ما من الخيرات الخطيرة النفيسة، مثل المُلك
والحكمة، أَو يكون الذي يتعجب منه عنده خير من الخيرات التي يكون
المتعجبون منه محتاجين إِليها جدا جدا، أَو يحتاج إِليها من هو رئيس على
المتعجب؛ وبالجملة: من هو أَرفع قدراً من المتعجب.
قال: والذين يحب الإِنسان أَن يكون مكرما عندهم هم أَشباهه من الناس، وذلك
إِما أَترابه وإِما قومه وإِما أَهل مدينته أَو أَهل صناعته. والصنف أَيضا
من الناس الذين يعتقد المرءُ فيهم أَن ظنونهم واعتقاداتهم فيه اعتقادات
صادقة من قِبَل أَنه يرى أَنهم ذوو لب وعقل، مثل المشايخ وذوي الآداب فإِن
الإِنسان يحب الكرامة من هؤلاءِ.
قال: والأَشياءً القبيحة التي هي ظاهرة للأَبصار، وفعلها علانية
هي مما يخزى المرء منها أَكثر من غيرها. ولذلك يقال في المثل: إِنما الخزي
فيما تراه العين. وإِذا كان الأَمر كذلك، فقد ينبغي أَن يكون الاستحياءُ
أَكثر من الذين هم أَبدا حضور وبالقرب من الإِنسان، ومن الذين ينظرون
إِليه من أَجل أَنهم منه بمرأَى العين. والذين لا يستحيون من هؤلاءِ فهم
صنف مذمومون من الناس، لأَنه معلوم أَن الذين يبصرون أَفعال الإِنسان
فإِما يحمدون وإِما يذمون. وتخيل عدم الحمد هو الذي يفعل الحياءَ كما تقدم.
قال: والصنف من الناس الذين لا يسترسل المرءُ إِليهم ويتحفظ منهم فقد
يستحي منهم. وهذا الصنف هم الذين يعتقد الإِنسان فيهم أَنه ليس عندهم رأي
يعبأ به ويعتمد عليه في الأَمر الذي أَخطأَ فيه أَو يظن أَنه أَخطأَ فيه،
حتى يكونوا هم الذين يسددونه إِن أَخطأَ فيه أَو يبصرونه ظنه. لأَنه إِنما
يسترسل الإِنسان في أَفعاله أَو يبوح بها عند خواص الناس، وهم إِما الصنف
من الناس الذي يعتقد فيهم أَن عندهم تسديدا له وتقويما، ولذلك لا يستحي
المتعلم من استاذه، وإِما الأَصدقاءُ الذين يطرح الإِنسان معهم المؤونة.
وإِنما كان المرءُ يتحفظ ممن عدى هذين الصنفين أَن يبوح لهم بقول أَو
يسترسل بحضرتهم في فعل لأَنهم يذمونه على ذلك، حتى أَنه إِن باح بشيءٍ
ظنه، ولم يكن كما ظن، أَعتقد فيه أَن ذلك الذي قد باح به قد فعله، وفضحوه
في ذلك، سواء كان ذلك الأَمر كما ظن، أَو لم يكن. ولذلك كان المظلوم لا
يفصح بالشر الذي يتوقعه بالظالم إِلا لهذين الصنفين من الناس، أَعني الذين
يعبأ بآرائهم ويعتمد عليها حيث يخاف الخطأ أَو الأَصدقاء.
قال: والصنف من الناس الذين يحفظون مساوئ الأَخلاق وينهونه عن الخطأ مستحى
أَيضا منهم وممقوتون.
وكذلك الصنف من الناس الذين انتدبوا لبث مساوئ المعارف وخطئهم كفعل
المزدرين المستهزئين. وأَعني بالمزدرين المخسسين للإِنسان، وبالمستهزئين
المحاكين له، أَعني الذين يحاكون الشيءَ على جهة الازدراءِ به، وهؤلاءِ
ممقوتون مستحى منهم. واسم الحشمة أَحق بهؤلاءِ الذين ذكرهم من اسم
الحياءِ، وذلك أَن الحياءَ يكون ممن يظن به خيرا، والحشمة تكون ممن يظن به
شرا. ولهذا كان الحياءُ من أَهل الشر ممزوجا بخوف. وممن يستحي المرءُ منهم
الذين لم يحقروه قط في شيءٍ لأَنه يحسب أَنه عندهم بمنزلة المتعجب منه.
وممن يستحى منه الذي احتاج إِليك في حاجة فقضيتها له، لأَنه عندك ممن
يمدحك ولا يذمك. ومن هؤلاءِ أَيضا - أَعني الذين يستحي الإِنسان منهم -
الذين يريدون أَن يستحدثوا صداقة الإِنسان، لأَنهم في هذه الحال إِنما
يعرفون منه الفضائل فقط فهو يستحي من أَن يقفوا على مخزى. ومن الذين يستحي
منهم الذين لم يطلعوا للإِنسان على شيءٍ يستحي منه.
قال: ثم إِنه ليس إِنما يستحيون من هذه القبائح التي ذكرت، بل من العلامات
والدلائل التي تدل علها. وذلك أَنه ليس من الزنا يستحيون فقط، لكن ومن
الدلائل التي تدل على الزنا. وكذلك ليس يستحيون من فعل الفواحش أَنفسها،
ولكن ومن النطق بها، لأَن النطق بها علامة أَو دليل على فعلها. فهؤلاءِ هم
أَصناف الناس الذين يستحى منهم.
وأَما الذين لا يستحى منهم فالذين يسترسل الإِنسان إِليهم ويطلعون على
أَمره. وهؤلاءِ صنفان: إِخوان ومساعدون. فأَما الإِخوان فهم الذين يطرح
معهم الإِنسان فعل الجميل الذي هو جميل عند الجمهور من غير أَن يكون
بالحقيقة كذلك. وأَما المساعدون فهم الذين يطرح معهم فعل الجميل بإِطلاق
كان جميلا في الحقيقة أَو في بادي الرأي. ومن الذين لا يستحي الإِنسان
منهم الذين يستخف بهم ويستحقرهم، لأَنه لا يبالي باعتقادهم فيه كان خيرا
أَو شرا ولا ما يكون عنهم من مدح أَو ذم، كما ليس يستحي أَحد من البهائم
والأَطفال.
قال: وليس استحياءُ المرءِ من معارفه ومن الأَباعد استحياء بجهة واحدة.
وذلك أَن الحياءَ الذي يكون بحضرة من يعرفك يكون مما هو في الحقيقة قبيح،
وممن لا يعرفك يكون مما هو في الظن والمشهور قبيح.
فهؤلاءِ هم أَصناف الناس الذين يستحى منهم والذين لا يستحى منهم.
وأَما أَصناف الناس الذين يوجد لهم هذا الانفعال كثيرا، أَعني
الحياءَ، فمنهم الذين يعتقدون في أَنفسهم أَنهم واحد من الأَصناف الذين
ذكرنا أَنه يستحى منهم مثل المتعجب منهم. والمتعجبون الذين ذكرنا أنَه
يستحى منهم فإِنه متى اعتقد إِنسان في نفسه أَنه واحد من هذين بادر إِليه
الخجل من أَدنى شيء مخافة أَن ينقص في عين الذي يتعجب منه، إِن كان يعتقد
في نفسه أَنه يتعجب منه. وأَما المتعجب من غيره فإِنما يسارع إِليه الخجل
بسبب أَن المتعجب من كل شيءٍ يعظم عنده كل شيءٍ فهو يتأَثر عن القبيح
اليسير ويخاف منه ما لا يخاف كثير من الناس. ومن هذا الصنف من الناس،
أَعني الذين يسرع إِليهم الحياءُ، الناس الذين يهوون أَن يكونوا عند غيرهم
متعجبا منهم. والذين يحتاجون إِلى الناس في ضرورات أَحوالهم يستحيون كثيرا.
قال: وقد يسرع الحياءُ إِلى الصنف من الناس الذين ليسوا بمحمودين في
الغاية ولا مذمومين، لأَنهم يخافون أَن يسارع إِليهم الذم. وهؤلاءِ هم
محمودون بقدر ما؛ فإِن الحياءَ ليس يكون ممن ليس بمحمود أَصلا.
قال: والإِنسان إِنما يستحي أَكثر ذلك حيث يكون الذي يستحي منهم ينظرون
إِليه.
قال: ولذلك لما أَراد فلان أَن تشتد أَنفة فلان لرجلين مشهورين عندهم من
قبل الخزي والعار الذي يلحقه في التواني في المحاماة عن اليونانيين أَوهمه
أَن اليونانيين قيام ينظرون إِليه ولم يجْترئ أَن يقول له إِن هذا سيصل
إِلى اليونانيين، وإِنما فعل هذا لتشتد أَنفته في المحاماة. ولذلك ما كان
ذوو الأَنفة والحمية إِذا امتعضوا لإِنسان ما أَو لناس ما في ضيم جرى
عليهم يتشوقون إِلى أَن يرى امتعاضهم الذين امتعضوا لهم حيث جرى عليهم ذلك
الضيم وخاب ظنهم في الظفر بالذي أَجرى عليهم ذلك الضيم، أَعني ضيم الذين
ضيموا.
قال: وما أَعجب ما يظهر من ذوي الحمية والأَنفة عند الأَفعال التي يستحى
منها وذلك في الأَمور التي تلحقهم أَو تلحق آباءهم أَو تلحق من يتصل بهم،
وبالجملة من يستحيون بسببه وهم الناس الذين ذكرنا. وكذلك تظهر منهم
الأَفعال العظيمة في النصرة والمحاماة للذين ينسبون إِليهم مثل المعلمين
لهم أَو المشيرين عليهم أَو المسودين لهم وكل من يشبه هؤلاءِ ممن يحبون
أَن يكموه فما أَكثر ما يفعل ذوو الحمية والأَنفس الكبار في أَمثال هذه
المواطن، ولا يغفلون عن شيء يوجب النصرة حتى (لا) يلحقهم عار من أَجل
توانيهم في ذلك. وأَكثر ما يكون هذا الفعل منهم إِذا توهموا أَن أُولئك
الذين امتعضوا لهم قيام ينظرون إِليهم وأَنهم لا يزالون يترددون بينهم،
فيتكرر الخزي والحياء منهم فيما توانوا فيه ووقعوا فيه من القبيح.
قال: ولذلك لما قَدَّم ملك من ملوك التَّغَلُّب الذين كانوا في اليونانيين
قوما منهم إِلى القتل وكان في جملتهم شاعر منهم، قال لهم حين ستروا وجوههم
وأَستحيوا من العار الذي لحقهم في قتله صبراً ! إِنما كان يجب لكم أَن
تفعلوا ذلك، يعني ستر وجوههم والحياء من هذا الفعل، لو كنتم غدا وبعد غد
تترددون حتى ينظر إِليكم اليونانيون مرة بعد مرة. وأَما وأَنتم مفقودون في
هذه الحال ولا تخافون أَن تنظروا بعد إِلى اليونانيين، فما يجب لكم أَن
تستحيوا.
قال: فهذه جملة ما قيل في الحياءِ. وأَما القول في الوقاحة فمعلوم أَنا
نقدر على معرفته من الأَشياءِ التي قيلت في باب الحياءِ إِذ كانت هي
أَضدادها، يعني أَنا نعلم في الوقاحة الأَشياءَ الثلاثة المضادة للأَشياءِ
الثلاثة التي علمناها في باب الحياءِ، أَعني ممن يستحي ومَن الذي يستحي
ومِن أَي الأَشياءِ يكون الحياء.
القول في إِثبات المنة
وشكرها وفي إِنكارها وكفرها
قال: فأَما معرفة من هو ممتن عليه وهو الذي يجب عليه الشكر، وما الأَشياءُ
التي هي مننٌ، ومَن الناس الذين يمتنون، وهي المواضع الثلاثة التي منها
يثبت الخطيب المنة، فنحن مبينون ذلك فنقول:
إِن المنة هي التي بها يقال لذي المنة أَنه ممتن. والأَشياءُ
التي إِذا فعلت كانت منة هي أَحد أَمرين: إِما خدمة وهو العون بالبدن،
وإِما صنيعة وهو العون بالمال أَو الجاه. وقد يكون العون بالبدن والمال من
قبل الجاه. وإِنما تكون الخدمة أَو الصنيعة منة إِذا كانت مما لا يستطيع
المصطنع إِليه أَن ينال تلك الخدمة أَو الصنيعة من إِنسان آخر غير
المصطنِع، وكانت المنة مع هذا أَيضا لا ينال الفاعلَ لها شيءٌ منها، ولكن
تكون كلها لمكان المصطنَع إِليه.
قال: وقد تكون الصنيعة جسيمة بالإِضافة، وإِن كانت في نفسها يسيرة بأَحد
خمسة أَشياء: أَحدها إِذا كانت عند شدة الحاجة إِليها، أَو في وقت ضيق لا
يلتفت فيه إِنسان إِنساناً مثل وقت الخوف الذي يذهل الناس فيه عن معونة
بعضهم بعضا، أَو كان هو وحده المصطنِع فقط، أَو كان هو المصطنع الأَول،
أَو كان الصنع منه زائداً على صنع غيره. والأَشياءُ التي تكون عندها شدة
الحاجة ثلاثة أَصناف: أَحدها المتشوقات لضروريات في الحياة مثل الغذاءِ،
والثانية الأَشياءُ التي يشتد شوق النفس إِليها وإِن لم تكن ضرورية مثل
اشتياق الفواكه. والثالثة ما كان من الأَشياء يحزن فقده أَو يؤذي. فإِن
المشتهيات المتشوقة هي هكذا، أَعني يحزن فقدها أَو يؤذي. والمشتهيات التي
بهذه الصفة صنفان: صنف مألوف ومشتهى وهي المتشوقات، وصنف يشتاقها الإِنسان
ويشتهيها عندما يكون في شدة وكرب. فإِن الذي يقع في الشدائد يشتهي الخروج
منها، وكذلك الحزن يشتهى انكشاف الحزن عنه. ولذلك ما تعظم المنة عند الذين
هم في حال خصاصة أَو هرب من أَعدائهم، أَعني إِذا أَخفوهم وستروهم عن
الطالب لهم، وإِن كانت الصنيعة في نفسها قليلة لكن تعظم لشدة الحاجة
وصعوبة الزمان.
فقد ظهر من هذا أَن الصنيعة اليسيرة تعظم عند أَمثال هؤلاءِ أَو عند الذين
يساوونهم، أَعني الذين أَحوالهم شبيهة بهذه الأَحوال في الحاجة أَو عند
الذين هم أَعظم من هؤلاءِ، أَعني أَحوالهم أَشد.
قال: وهو معلوم أَنه يستبين من هذا الذي قد قيل مَن الذي يمتن عليه، وبأَي
شيءٍ تكون المنة، ومن الممتن، وأَنا نستطيع من قبل هذا الذي قيل أَن نثبت
هذه الأَشياء الثلاثة. مثال ذلك: أَن الذين لا يخبرون بما فعلوا من
الإِحسان هم ممتنون، وإِن الذين وصلتهم الصنيعة وهم في غموم وفاقة مثل
الذي تقدم ذكرهم أَنهم ممتنون عليهم، وأَن أَفعال الصنائع التي تصطنع عند
أَمثال هؤلاءِ وفي أَمثال هذه الأَوقات أَنها منة.
قال: وهو معلوم أَيضا من أَين تؤخذ المقدمات التي تدفع بها المنة وتوجب
الجحود لها، وذلك يكون بوجوه ثمانية: أَحدها أَن تكون الصنيعة من أَجل
المصطنِع، أَعني أَن تكون منفعتها عائدة عليه. والثاني أضن تكون الصنيعة
أَقل مما يجب. والثالث أَن تكون بحيث لا يحتاج إِليها فإِن هذه ليست بمنة.
والرابع أَن تكون الصنيعة وقعت بالمصطنَع إِليه باتفاق، لا بقصد. والخامس
أَن تكون الصنيعة بكره واضطرار. والسادس أَن تكون الصنيعة قصد بها
المكافأَة على صنيعة أُخرى تقدمت من المصطنَع إِليه إِلى المصطنِع.
والسابع أَن تكون الصنيعة قصد بها إِذاعتها والمن بها. والثامن أَن يكون
المصطنِع كلف المصطنَع إِليه أَمراً ما أَو حاجة له. وذلك أَنه من المعلوم
بنفسه أَنه لا تكون صنيعة توجب الشكر إِذا وجدت بحال من هذه الأَحوال
الثمانية. وقد ينتفع بهذه المقدمات في الشكاية في كفر الصنيعة وجحدها
والتنصل منها، وذلك أَنه إِنما تكون منه إِذا كانت كما قيل من أَجل
المصطنَع إِليه وبمقدار الحاجة وفي الوقت الذي لا يجد فيه ناصراً وفي
الموضع الذي فرّ إِليه. ومن العلامات الدالة على المنة أَلا يكونوا قد
قصروا في الصنيعة، وأَلا يكونوا فعلوا ذلك بالأَعداءِ، فإِنه يظن أَن
فعلهم ذلك كان من أَجل كف شرهم، أَو يكونوا فعلوا ذلك بمن استوجب عندهم
حقا مثله أَو أَعظم منه إِن لم يكن أَولئك إِنما استوجبوا عندهم الحق من
قبل شيءٍ وصل إِليهم هو في الحاضر شر وفي المال خير مثل التأْديبات
والشرور التي تكون بعدل وهي التي تكون على طريق المكافأَة فإِن أَحدا لا
يعترف أَنه يحتاج إِلى الشر، وإِن كان طريق العدل. ولذلك ليس يراه منةً
لأَحد.
قال: والقول في إِثبات المنة وجحودها يكون من هذه المواضع.
القول في الاهتمام
فأَما عن ماذا يكون الهم، ومَن يهتم، وبمن يهتم، فإِنا مخبرون
ذلك. فليكن الهم حزنا ما يلحق من قبل شر مفسد أَو محزن يعرض للمرءِ بلا
استيجاب، وذلك إِذا كان الشر يتوقع أَن يحدث عليه أَو على أَحد ممن يتصل
به وكان قريب التوقع. وأَعني بالمفسدات التي تغير البدن، وبالمحزنات التي
تفعل الأَذى النفساني. وإِذا كان حد الاهتمام هو هذا، فهو بين أَن غير
المهتم يكون بهذه الحال التي أَصف، وهو أَن يظن أَنه ليس شيءٌ من الشرور
واقعاً لا به ولا بأَحد ممن هو بسببه، أَعني مثل هذا الشر الموصوف في الحد
أَو شبهه أَو قريبا منه. فإِن المتهم هو الذي يتوقع نزول مثل هذا الشر به
مع رجاء للخلاص منه. ولذلك لا يهتم الذين قد نزلت بهم الشرور العظيمة مثل
الذين عطبوا، ولا الذين يظنون أَنهم سعداء. وذلك أَن الذين يظنون أَنهم
سعداء، يظنون أَنهم لا ينالهم شيءٌ من الشر، إِذ كانوا يرون أَن ذلك من
السعادة، أَعني أَلا ينالهم شر. ومن هؤلاءِ أَيضا، أَعني الذين لا يهتمون،
الذين يظنون أَنهم لا يأْلمون لا من قبل أَبدانهم ولا من قبل نفوسهم، وذلك
من قبل أَنهم قد لقوا شرورا فتخلصوا منها، وإِما من قبل أَنهم مشايخ قد
طالت مزاولتهم للشرور، وإِما من قبل كثرة التجربة، وإِما لمكان عادة جرت
لهم فتطيب نفوسهم كطيب نفوس المقبلين السعداءِ، وإِما لمكان شهرتهم في
الناس وذلك أَن المشهورين يرون أَن الشرور بعيدة عنهم لمكان علو أَقدارهم
وأَن الناس كلهم معينون لهم. وقد يعرض هذا الظن لمكان التأَدب بالصنائع
والأَشياءِ التي تدفع بها الشرور. ومن هؤلاءِ القوم الذين ظنونهم حسنة
جميلة لمكان وجود الآباء لهم والأَبناء والنساء بالأَحوال الجميلة، أَعني
الذين لم تثكلهم ولا أَحزنتهم الأَيام في واحد منهم. وبالجملة: الذين عرض
لهم في هذه الأَصناف الثلاثة جودة الاتفاق. فإِن الشرور المتصلة بهؤلاءِ
تصير الإِنسان ضعيف النفس مهتما بأَدنى شيءٍ يخافه. ومن هؤلاءِ: الذين
تعتريهم وتوجد فيهم الانفعالات التي تخص الشجاعة، مثل الغضب وشدة القلب،
فإِن هؤلاءِ غيرُ ذوي فكرة فيما يتوقع. ومن هذا الصنف أَيضا الناس الذين
من أَخلاقهم الشتم والاستهانة، فإِن هؤلاءِ أَيضا لا يهتمون، لأَنهم لا
يتوهمون أَنه يقع بهم شر، وذلك لنقص فطرهم. والناس الذين يهتمون هم خائفون
جدا جدا لا يهتمون بغيرهم، لأَن المكروبين من الخوف لا يهتمون بآخرين،
لأَنهم مشغولون بالأَلم الخاص الواقع بهم. والذين يظنون بأَحد أَنه حقير
خامل فليس يهتمون به، لأَنهم يرونه أَهلا لوقوع الشر به، أَو لا يرون أَن
وقوع الشر به شر. ولذلك كما يقول أَرسطو: من ظن أَنه ليس في العالم أَحد،
فقد يظن الناس جميعا مستوجبين للشر. وبالجملة فإِنما يهتم المرءُ إِذا كان
بهذه الحال التي وصفنا، أَعني إِذا كان يتوهم ويتخيل أَن شيئا من أَضداد
هذه الأَشياء التي يتخيلها الذي لا يهتم توجد فيه أَو فيمن يتصل به.
فهذا جملة ما قاله في وصف أَحوال الذين يهتمون.
قال: وأَما أَي أَشياء هي التي تفعل الهم، فمعلوم مما قيل في حد الاهتمام.
وذلك أَن جميع ما كان من المفسدات، أَعني المغيرات للبدن، وما كان من
المحزنات أَعني المغيرات للنفس، فكلها فاعلة للاهتمام، وبخاصة ما كان من
المفسدات القاتلة، وما كان من أَنواع الشرور التي اشتمل عليها الحد بأَشد
ما يكون.
قال: ومن المفسدات المؤديات إِلى الموت: أَوجاع البدن والجهد والكبر
والسقم والحاجة إِلى القوت.
قال: وعدم الإِخوان أَو قلتهم، لما كان من سوءِ الجد، فقد يكون ذلك من
الشرور المفسدة التي تهم.
قال: ومن فاعلات الاهتمام الأَحوال التي جرت العادة، إِذا كانت بالناس،
أَن تفعل الاهتمام بهم، مثل الأَحوال التي يكون عليها ذوو السقم والزمانة
من قبح المنظر والقعود عن الحركة والتصرف. ومما يفعل الاهتمام أَن يصير
المرءُ إِلى الشر من حيث أَمل أَن ينال الخير، أَو أَن يصير إِلى أَمر
كبير: إِما يكون الذي يصير إِليه يصيب خيرا فلا يكون له شيءٌ من الخير فيه
أَلبتة، أَو أَن يكون يصير إِلى خير في الوقت الذي يفوت الاستمتاع بذلك
الخير، مثل اليسار في وقت الهرم.
قال: فهذه جملة الأُمور التي تفعل الهم.
قال: وأَما بمَنْ يهتم، أَعني من الغير، إِذا توقع نزول الشر به
أَو يرثى له إِذا نزل به ويرحم، فإِن هذا هو الفرق بين الاهتمام والرحمة.
فالمعارف ومن هم بالإِنسان بسبب، إِن لم يكونوا في غاية القرب من الإِنسان
حتى يكون الشر الواقع بهم هو شر واقع بالإِنسان مثل الولد والوالد.
قال: ومن هنا قيل إِن فلانا لرجل مشهور عندهم لما جُلد ابنه وأَشفى من ذلك
على الموت لم تدمع عينه ولا حزن. ولما رأَى صديقا له يَسئل من فاقة جزع
واهتم.
قال: وإِنما يكون الهم بالغير إِذا توقع حدوث الشر به، أَو الرحمة له إِذا
وقع به، لأَن توقع حدوث الشر بالإِنسان نفسه أَو ممن يتنزل منزلة نفسه أَو
وقوعه به هو شدة نزلت بالإِنسان، أَو يخاف نزولها. ونزول الشدائد
بالإِنسان أَو تخوف نزولها به أَو بمن هو بمنزلة نفسه ومسلاة عن الاهتمام
بغيره أَو الرحمة له. وإِذا نزل الشر بالإِنسان فلا يقال إِنه يرحم نفسه،
ولا إِذا توقع نزوله لم يقل فيه إِنه مهتم ولكن خائف.
قال: ومِن الذين يهتم بهم هماً أَكثر: الصنف من الناس الذين هم أَشباه
الإِنسان، أَعني في الهمم والأَخلاق والمراتب والأَحساب، إِذا كانت
الشدائد قريبة الوقوع بهم.
قال: وبالجملة كلما يخافه الإِنسان على نفسه فهو يهتم به إِذا تخوفه على
الخير. وذلك إِذا تخيل أَن تلك الآلام والشرور قريبة الوقوع، لأَن الشرور
المتخيلة إِنما تكون من أَسباب الهم إِذا تخيلت بهذه الجهة. فأَما الشرور
التي يتخيل وقوعها فيما سلف، مثل السنين الكثيرة، فليس يهتم بها ولا تخاف.
وذلك أَنها ليست مستقبلة فتتوقع. ولا الذكر أَيضا مما يفعل الخوف
والاهتمام. وكذلك الممتنعة الوجود لا تخاف أَلبتة ولا يهتم بها.
قال: وقد يهتم الإِنسان للناس الذين يخيلون بأَصواتهم وهيئاتهم المحسوسة
أَنه قد نزل بهم شر أَو قد قارب أَن ينزل لأَنه بما يخيلون من ذلك يجعلون
الشر بحيث يتخيل أَنه قريب ويجعلونه نصب العين أَو كأَنه قد وقع. لأَن
الهم إِنما يكون في الأَشياءِ التي قد وقعت الآن أَو يتوقع من قرب نزولها.
وظهور العلامات والدلالات التي تدل على الشرور، مثل الأَحوال التي ذكرناها
من أَحوال الخائفين، إِنما تفعل الهم إِذا دلت عليه بهذه الحال، أَعني
أَنه قد حدث أَو قارب حدوثه، وبخاصة إِذا ظنوا أَن أُولئك الذين ظهرت
علامات الشر عليهم هالكون، ولا سيما إِذا كان أُولئك الذين ظن بهم الهلاك
أَفاضل، وأَكثر من ذلك إِن كان هلاكهم في الوقت الذي الحاجة إِليهم أَكثر
أَو الرجاء فيهم أَمكن مثل اَن يعتبطوا أَو يموتوا شبابا. فهذه كلها تفعل
الاهتمام أَكثر من غيرها، أَعني هلاك الفضائل بهلاك الفاضلين الذين لا
يستحقون ذلك في الوقت الذي الحاجة إِليهم فيه شديدة، من قبل أَنه إِذا
وقعت أَمثال هذه الأَشياء أَو دلت العلامات والدلائل على وقوعها، ظن أَن
الشر قريب حتى كأَنه يرى نصب العين.
قال: وقد يوجد الاهتمام والجزع انفعالات مضادة، أَعني مبطلة، ولا سيما
الحزن الذي يكون على الذين ينالون خيرا بلا استئهال، وهو الذي يسمى نفاسة.
لأَن الاهتمام هو الحزن على الشر الذي ينال من لا يستأهله. وهذا الانفعال
الآخر هو خلق شريف، أَعني الحزن على من نال خيرا بلا استئهال، وذلك أَن
الذين يصيرون إِلى غير ما يستأهلونه من خير أَو شر، فينبغي أَن يحزن لهم
جدا جدا. والذين يصيرون إِلى الشر من الأَسباب المعروفة والطرق المعتادة
التي بها يفضي الإِنسان ويحكم على مصيرهم إِليها، فقد يرى الناس أَنهم
أَهل لذلك. وأَما الذين يصيرون إِلى هذه الأَشياء من طرق غير معروفة
فينبغي أَن يكونوا في الوسط من أُولئك، أَعني أَلا يعتقد فيما أَصابه من
الشر أَنه كان باستئهال أَو بغير استئهال، بل ينبغي أَن يفوض أَمرهم إِلى
الله. لأَن ما نال الإِنسان من الجور والشر من طرقه المعروفة، فسببه الجور
والشرارة التي في ذلك الإِنسان، وأَما ما ناله من ذلك من غير طرقه
المعروفة، فإِنا نكل علم ذلك إِلى الله عز وجل.
قال: والحسد أَشد مضادة للاهتمام من الحزن الذي يكون على الخير
الذي ناله من لا يستأهله، وهو الذي قلنا إِنه يسمى نفاسة. وكأَن هذا
الانفعال قريب من أَن يكون في الوسط، أَعني بين الاهتمام والحسد، لأَنه
قريب من الحسد، وذلك أَنه اغتمام بخير، كما أَن الحسد اغتمام بخير. وإِنما
الفرق بينهما أَن الحسد اغتمام بخير ناله من يستحقه، وهذا اغتمام بخير
ناله من لا يستحقه.
قال: وليس الحسد هو الاغتمام الذي ينال الإِنسان لخير أَصابه مستحقه
وأَخطأَه في نفسه، لأَن هذا لا يعْرى منه أَحد، ولا هو أَيضا الاغتمام
الذي يناله من قبل أَنه يعتقد أَن ذلك الخير الذي أَصاب المستحق لو لم
يصبه لكان سيصيبه، وذلك أَن الاغتمام بالخير الذي أَصاب غيره ولم يصبه هو
اغتمام لأَنه لم يعط ذلك الخير ولم يرزقه. والاغتمام بالخير الذي حرمه من
أَجل إِصابته لغيره هو اغتمام من قبل أَنه نالته شقاوة بسبب سعادة ذلك.
وإِذا كان الأَمر هكذا فالحسد هو الاغتمام بخير يناله المستحق له، لا لأَن
ينال هو ذلك الخير.
قال: وهو معلوم أَنه قد يلزم من الاغتمام بنزول الخير والشر بمن يستأهله
ومن لا يستأهله انفعالات متضادة. فإِن الذي يحزن لنيل الخير مَن يستأهله
ومَن لا يستأهله قد يؤلمه هذا إِذا وقع ويبرؤه من هذا الأَلم وقوع الشر
بهم بأَسوإِ ما يكون، أَعني الشرار الذين لا يستأهلون الخير. ولذلك الصنف
من الناس الذين يضربون آباءهم أَو يتدنسون بالقتل،إِذا وقعت بهم العقوبة،
فليس أَحد من الناس يحزن لهم، بل يفرحون بهذا ويرونه خيرا، لأَنه بمنزلة
الفرح الذي يكون إِذا نال الخير المستأهلون له. وذلك أَن الأَمرين جميعا
عدل. ومما يسر به الخيار والحكماءُ نزول الخير بمن يستأهله ونزول الشر
أَيضا بمن يستأهله. وذلك أضن هذين الأَمرين جميعا، إِذ كانا معا عند
الحكماءِ جميلين، فهما جميعا من خلق صنف واحد من الناس، وكلاهما يشتاق
إِليه هذا الصنف من الناس. وأَما ضد هذا، وهو الاغتمام بالخير الذي ناله
المستحق له، فهو موجود لضد هذا الخُلق، لأَن الذي لا يفرح بهذا ويحزن له
هو صنف واحد من الناس وهم أَهل الشرارة والحسد. فإِنه ولا بد إِذا كان
المرءُ يحزن لكون شيء ووجوده أَن يكون يفرح بعدمه وفساده.ولذلك مَنْ كان
من الناس يحزن لوجود الخير لمن لا يستأهله، فهو يفرح بعدم الخير لهم ووجود
الشر. وبالعكس. أَعني أضن الذين يفرحون بوجود الخير لمن يستأهله، يغتمون
بعدمه ووجود الشر لمن يستأهله، وهو الذي يسمى أَسى وأَسفا.
قال: وكل هذه الانفعالات التي تتركب من هذه الأَشياء، أَعني من الخير
والشر وممن يستأهل ومن لا يستأهل، تشترك كلها في أَنها تضاد الهم. وهي
وإِن كانت مختلفة لمكان التركيب، فهي كلها تجتمع في أَنها تصلح أَن تستعمل
في نفي الهم.
القول في النفاسة
قال: ونحن الآن قائلون أَولا في النفاسة وذلك بأَن نخبر على مَن ينفس من الناس وفيما ينفس ومَن الذين ينفسون، ثم نقول بعد ذلك في تلك الأٌخر التي عددنا، أَعني الحسد والأَسف، فنقول: إِنه إِن كان النافس هو الذي يحزن لحسن حال تكون للمرءِ بلا استحقاق، فهو معلوم من هذا الحد نفسه أَنه ليس تكون النفاسة في جميع الخيرات، لأَنه ليس ينفس على أَحد في الشجاعة ولا في البر، وبالجملة في جميع الفضائل التي تكون للإِنسان عن الإِرادة. كما أَنه ليس يهتم المرءُ بوجود أضداد الفضاءل له، وإِنما تكون النفاسة في المال والقوة، وبالجملة في الخيرات التي تصيب الإِنسان من خارج، مما قد يرى أَن الخيار يستحقونها، وأَن الشرار لا يستحقونها. وإِنما ينفس في هذه إِذا كانت حديثة. فإِن المتقادمة من ذلك يظن بها أَنها قريبة من الأَمر الواجب الذي في الطبع، ولذلك لا ينفس في الأَموال الموروثة، ولا في الرياسات المتقادمة في الأَكثر؛ وإِنما ينفسون لا محالة في الخيرات المستحدثة، مثل: السلطان المستحدث، وكثرة الإِخوان، والمال، وغير ذلك من الخيرات. والسبب في هذا أَن الناس هم أّشد غيظا من الذين يستغنون حديثا منهم على الذين يكون الغنى فيهم متوارثا، وكذلك الأَمر في سائر الخيرات التي من خارج. والسبب في ذلك شيئان: أَحدهما أَنهم يرون أَن ذلك الخير الحادث هم كانوا أَحق به منهم.والثاني أَنهم رون أَن الواجب فيه كان استصحاب الأَمر القديم له
وهو الفقر مثلا أَو الضعة. ولذلك لا ينفسون في الخيرات المتقادمة لأَنها
مما قد اعتيدت، وكأَنها واجبة لهم. والخير الذي لا يستأهله المرءُ عند
النافس عليه يختلف. وذلك أَن الخير الذي يستأهله واحد واحد من الناس يختلف
في المشاكلة والمقدار، وذلك أَنه ليس كل خير يشاكل كل إِنسان، ولا المقدار
من ذلك واحد، بل لكل إِنسان خير مشاكل ومقار ملائم. فإِن حمل السلاح
والهيئات الحربية هي خيرات، ولكنها غير لائقة بالنساك، وإِنما هي لائقة
بأَهل الشجاعة. وكذلك الإِسراف في النكاح لا يليق بالذين غناهم حديث
وإِنما يليق بالذين لهم قديم غنى، لأَن الحديث الغنى يحتاج إِلى حفظ
اليسار. وأَما القديم الغنى فكأَن غناه شيءَ ثابت لا يخاف عليه. فإِذا كان
المرءُ يليق به خيرٌ ما فلم ينله أَغتم وحزن.
قال: وإِذا نال الإِنسان من الخيرات ما هو أَعظم منه في الكيفية أَو
المقدار، فإِنه من العطية والرزق والمقدور الذي يقال فيه إِنه من عند الله
تعالى، وذلك مثل أَن يظفر الصغير بالكبير إِذا نازعه، والخسيس بالشريف،
والمسيءُ بالناسك. وإِلا فما كان بالناسك. وإِلا فما كان للمسيء أَن يظفر
بالناسك، فإِن الناسك أَفضل من المسيء. ومن هاهنا تتبين الخيرات التي يقال
فيها إِن الناس ينالونها بقدر من الله، والناس الذين يقال فيهم ذلك. وذلك
أَن هذه الخيرات وأَمثال هؤلاءِ الناس هم الذين تنسب الخيرات النازلة بهم
إِلى القدر. ومن الناس الذين ينفس عليهم الذين تصير إِليهم الخيرات
العظيمة. لأَنه ليس يرى أَحد أَن من العدل أَن تصير الخيرات العظام التي
يستأهلها الخيار من الناس إِلى الشرار منهم. ولذلك يأسف الإِنسان وينافس
إِذا كان الخيار الأَفاضل لا يقدرون أَن يظفروا بما يستحقون ويظفر به من
دونهم. وأَما الذين ينافسون فهم الناس المحبون للكرامة وسائر الأُمور التي
يظفر بها من لا يستأهلها. فإِن هذا الصنف من الناس بالجملة يأسف وينافس في
جميع الأُمور التي يرون أَنفسهم أَهلا لها ولا يرون غيرهم أَهلا لها إِذا
فاتتهم ونالها الغير، فعلى هذه الأَصناف من الناس الذين كرنا وفي
الأَشياءِ التي ذكرنا يأَسف وينافس المنافسون. وهذا الصنف الذي ذكرنا هم
المنافسون من الناس. ولذلك مالا يكون المقتنعون من الناس والذين يرون أَن
عندهم حيلة في استجلاب الخيرات منافسين، لأَن المقتنعين ليس يرون أَن
هاهنا أَشياءُ هم أَولى بها من غيرها. وإِن رأَى ذلك أَصحاب الحيلة، فليس
يرون أَنها تفوتهم.
قال: وهو معلوم مما قيل في هذا الباب وفي الذي قبله من أَي الأَشياء إِذا
وقعت يستحي الإِنسان الإِنسان ويخزى جدا إِذا هو لم يفرح بما يوجب الفرح
منها ولم يغتم بما يوجب الغم منها. ومن هذه الأَشياء التي ذكرت يمكن أَن
يستمال الحاكم إِلى النفاسة على الخصم أَو الرحمة له أَو الاهتمام به.
وذلك أَنه إِذا كان هاهنا ناس يستأهلون الخير وأَنهم قد ظفروا وأَنجحوا،
أَو كان هاهنا ناس غير مستأهلين فلم يظفروا ولم ينجحوا، فليس ينبغي أَن
يجزع عليهم بل يفرح بذلك. وبالعكس. أَعني إِن هاهنا ناس يستأهلون الخير
فلم يظفروا، فقد ينبغي أَن يشفق عليهم وأَن يهتم بهم.
القول في الحسد
قال: وهو معلوم مَنْ الناس الذين يَحسدون، وفيما يكون الحسد ومَن
الناس الذين يُحسدون، إِذا وضعنا أَن الحسد هو حزن يعرض للمرءِ من أَجل
نجح الغير وسعادته، وذلك إِذا وجدت له من الخيرات مثل الخيرات التي ذكرنا
في باب النفاسة وجودها لأَناس يستأَهلونها وتليق بهم. وكان ذلك الحزن من
الحاسد ليس لأَنه يهوى أَن يكون له ذلك الخير فقط، أَو يزول عن المحسود
ويكون له، بل لأَن يزول فقط عن المحسود. وإِذا كان الحسد هو هذا، فهو ين
أَن الحاسد إِنما يحسد الصنف من الناس الذين هم أَشباهه وأَمثاله أَو يظن
بهم أَنهم أَشباهه وأَمثاله. وأَعني بالأَشباه المضارعين للمرء في الجنس
وفي النسب وفي القنية وفي الحمد وفي المال. فهؤلاءِ هم المحسودون. وأَما
الحساد فمنهم الناس الذين شافهوا الكمال في الخيرات التي يحسد عليها إِلا
أَنهم لم يكملوا في ذلك ولا نالوا كل الخيرات ولا فاتهم جميعها بل يسير
منها. ولذلك مالا يوجد فاعلو الأَفعال العظيمة، أَعني ذوي الأَقدار
العظيمة والسعداء المنجحين في الأَشياءِ الإِنجاح التام، حسادا لأَنهم
يرون أَنه لم يفتهم شيء وأَن كل شيءٍ لهم. وكذلك الصنف من الناس الذين
يشرفون بشيءٍ من الأَشياءِ ويكرمون بسببه، ولا سيما بالحكمة وصلاح الحال.
ومحبو الكرامة أَشد حسدا من الذين لا يحبون الكرامة. والذين هم حكماءُ
محبون أَن يكرموا بالكرامات التي يكرم بها الحكماءُ، ولذلك يَحسدون الذين
يكرمون بهذه الكرامات. وبالجملة: إِن كل من يحب أَن يحمد على شيءٍ من
الأَشياءِ فإِنه يَحسد غيره في ذلك الشيءِ بعينه. فلذلك الذين يحبون أَن
يكرموا على شيءٍ ما يحسدون على ذلك الشيءِ بعينه.
قال: والناس الصغار النفوس هم أَيضا حساد لأَن كل شيءٍ عظم عندهم يحسدون
عليه، وإِن كان في نفسه صغيرا، حتى إِنهم قد يحسدون على كثير من الشرور
الواقعة بالناس.
فهؤلاءِ هم أَصناف الحساد من الناس.
وأَما فيما يحسدون: فقد يحسدون في الرغبة في الحمد أَو في التشوف إِليه
وفي الجلالة والنباهة بالمال والعبيد. وبالجملة في وجوه السعادات والنجح
كائنا ما كانت وفي كل شيء حسد ولا سيما في الأُمور التي يشتهونها أَو
يظنون أَنه يجب أَن تكون لهم. ومن الحساد الذين هم أَرجح من الإِنسان في
المال قليلا أَو أَنقص منه قليلا.
قال: وهو معلوم أَيضا كما قلنا مَن يحسدون. فقد قلنا إِنهم يحسدون الذين
هم قريب منهم في الزمان، والمكان، والحمد والمجد؛ ومن هنا قيل: إِن
المضارعة بين الناس قد تُحْسِنُ الحسد. والحسد إِنما يكون في الصنف من
الناس الذين لهم عند الإِنسان قدر ما قريب منه، وذلك إِذا كانوا في زمان
واحد أَو قريب، أَو في مكان واحد أَو قريب. ولذلك لا يحسد الشيخ الصبي،
ولا يحد الذين يأتون بعد في الزمان، ولا الذين غبروا. وهلكوا وبخاصة منذ
سنين كثيرة. وكذلك لا يحسد البعداءُ في المكان من الخيار. فإِن خيار
اليونانيين مثلا لا يحسدون الخيار الذين يكونون بأَصنام هرقل من جزيرة
الأَندلس التي هي بلادنا. وكذلك لا يحسد الإِنسان الذين هم أَنقص منه
بكثير، ولا الذين هم أَكمل منه بكثير، وإِنما يحسد من بينه وبينهم مشاركة،
وذلك كالمتنازعين في شيءٍ واحد والمحبين لشيءٍ واحد. وبالجملة: كل
إِنسانين يشتهيان شيئا واحدا، فكل واحد منهما يحب أَلا يكون لصاحبه وأَن
يتوحد به وينفرد. ولذلك كان الحسد أَحرى أَن يكون لهؤلاءِ، وذلك كالفاخر
والمفاخر، فإِن هؤلاءِ يشتهون شيئا واحدا، وكل واحد منهما يحب أَن ينفرد
به. وإِنما يحسد الفاخر للمفاخر في الأَشياءِ التي إِذا اقتناها كان بها
شبيها له. والحزن بهذه الأَشياء أَولا والأَسف عليها إِذا تمكن من النفس
حدث عنه الحسد للذين توجد لهم هذه الخيرات، أَو هي مزمعة أَن توجد لهم،
أَعني في المستقبل، أَو قد وجدت، أَعني فيما سلف. ولذلك قد تدخل الأَشياءُ
التي قيلت في باب الأَسف والنفاسة في باب الحسد، لأَن الأَسف إِذا تمكن من
النفس عاد حسدا.
قال: ومن كان من الغلمان أَكب رسنا فهو يحسد من هو أَصغر منه، إِذا نال
الأَصغر خيرا لم ينله الأَكبر، أَو نال خيرا مثله. وكذلك يحسد من ينال
الشيء بتدبير أَكثر لمن يناله بتدبير أَقل. وكذلك الذين أَدركوا بجهد
وإِبطاء ونصب يحسدون الذين أَدركوا بسهولة وسرعة.
القول في الغبطة
قال: وهو معلوم أَيضا فيما يغبط الغابطون ولمن يغبطون وبأَي
أَحوال يكون الغابطون إِذ كانت الأَشياءُ التي عليها يغبط هي ضد الأَشياء
التي بها يحزن وعليها يحسد وكان قد تقدمت لنا معرفة هذه الأَشياء، وكذلك
الذي يَغْبِط هو ضد الذي يحسِد، والذي يُغبَط ضد الذي يحسد. ولذلك إِن كان
الحسد هو اغتمام بخير يناله من يستحقه، فالغبطة هي فرح بخير يناله من
يستحقه.
قال: وهو معلوم لنا من هذه الأَشياء كيف يتهيأ لنا أَن نستميل الحكام بأَن
نصيرهم بأَحد الانفعالات التي توجب عندهم أَن ينال أَحد المتحاكمين منهم
خيرا والآخر شرا، مثل أَن يصير الحاكم ذا إِشفاق على أَحدهما وذا حسد
للآخر.
القول في الأَسى والأَسف
قال: وأَما بأَية حال يوجد الأَسفون وفيما يأسفون وعلى من يأسفون فمعلوم
أَيضا إِذا وضعنا أَن الأَسى والأَسف هو حزن ما يرى في الوجوه لفقد خيرات
شريفة يهواها المرءُ لنفسه أَو لمن هو بسببه، وذلك إِذا كانت من الخيرات
الممكنة، وكان ذلك الإِنسان بحسب طبعه أَو جنسه أَو سلفه ممن يستأهل ذلك
الخير من غير أَن يهوى أَلا تكون تلك الخيرات لغيره، وإِنما يهوى أَن تكون
له ويحزن من أَجل أَن لم تكن له. وإِذا كان الأَمر هكذا، فبيّن أَن الأَسف
والأَسى خير، وأَنه لا يكون إِلا للخيار، وأَن الحسد شر وخسران، وأَنه لا
يكون إِلا للشرار. وذلك لأَن الأَسى يصير المرءُ بحيث يصير مستعدا لأَن
ينال الخيرات ويستأهلها، لأَن هذا الانفعال لا يعرض إِلا لمن يرى نفسه
مستعدا للخيرات وأَهلا لها، فيكون ذلك سببا لاقتناءِ الفضائل.
وأَما الحسد فإِنه يصير المرء بحيث يكون مهيأ لأَن لا ينيل أَحداً خيراً.
قال: والذين يأسفون هم الذين يروْن أَنفسهم أَهلا لخيرات ليست لهم، لأَنه
ليس أَحد يكترث بالأُمور التي هي يسيرة الخير، أَو بالأُمور التي هي
مذمومة، ولا بالأُمور التي لا يرى نفسه أَهلا لها. ولذلك ما يوجد بهذه
الحال الأَحداث والكبيرة نفوسهم والذين تكون لهم الخيرات التي يستحقها جلة
الرجال والخيار، كاليسار وكثرة الإِخوان، يأسفون أَيضا على ما فاتهم من
هذه الخيرات. وذلك أَن من كان له يسار يأسف على ما فاته من الرياسة، ومن
كانت له رياسة دون يسار يأسف أَيضا على ما فاته من اليسار. وقد يأسف
هؤلاءِ على ما فاتهم من الزيادة والكثرة في هذه الخيرات مما يوجد لغيرهم.
وإِنما كان هؤلاءِ يعتريهم هذا الانفعال، لأَنه يخيل لهم في أَنفسهم أَنهم
خيار أَو قريب من أَن يكونوا خياراً، إِذ كان يوجد لهم الشيءُ الذي
يستأهله الخيار. مثال ذلك أَنه إِذا حاز الرياسة واليسار أَحد ظن أَنه
خيّر. إِذ كان هذان إِنما يستأهلهما الأَخيار. وإِذا ظن ذلك أَصابه الأَسف
على ما فاته من ذلك.
قال: والصنف من الناس الذين يكون آباؤهم الأَولون وأَقاربهم مكرمين قد
يعتريهم كثيرا هذا الانفعال عند أَمثال هذه الخيرات، لأَنهم يرون أَنها
أَهلية وأَنهم لها مستحقون. وإِذا كانت الأُمور التي فيها يكون الأَسى
والأَسف أُمورا مكرمة، أَعني شريفة عظيمة. فواجب أَن تكون إِما فضائل
نفسانية أَو أُمورا فاضلة، أَعني خيرات بدنية أَو خيرات من خارج، وذلك مثل
جميع الأَشياء التي فيها للغير إِما منفعة وإِما حُسن وجمال وإِما لذة.
ولذلك قد يكرم الناس أَهل هذه الأَصناف الثلاثة، أَعني المحسنين إِليهم
وهم أَهل المنفعة، والخيار وهم أَهل الجميل والفعل الحسن، والصنف من الناس
الذين فيهم مستمتع، وهم الملذون، وسواء كان الإِحسان منهم والاستمتاع بهم
لنفوسهم أَو لمن يتصل بهم. ولكون الأَشياء التي يتأَسف عليها هي الأَشياءُ
التي فيها للغير خير ما إِما جميل وإِما نافع وإِما لذيذ، كان الأَسف في
اليسار والجمال أَحرى منه في الصحة.
قال: وهو معلوم أَيضا من الحد مَن الناس الذين يأسى المرءُ ويأسف
على أَلا يكون له حالهم. وذلك أَن الأَسى إِنما يكون على أَحوال الناس
الذين توجد لهم الأُمور المكرمة التي ذكرناها مثل الجمال واليسار والشجاعة
والحكمة والرياسة. وإِنما صارت الرياسة من الأُمور التي يأسف الناس على
فقدها لأَن أَهل الرياسات يقدرون على الإِحسان إِلى أَكثر الناس، ومن
أَعظم أَفعالهم التي يفعلون بها ذلك قود الجيوش والخطابة إِلى غير ذلك من
ملكات الرياسات وأَحوالها التي يفعلون بها الإِحسان إِلى الناس. وكذلك كل
من ينحو نحو الرؤساءِ ممن له ملكة رياسية أَو حالة رئيسية يصدر منها
إِحسان إِلى الغير.
ومن الناس الذين يأسى المرءُ على أَلا يكون مثلهم الذين يود كثير من الناس
أَن يكون مثلهم، وأَن يكونوا من معارفه. ومن هؤلاءِ أَيضا الذين يتعجب
منهم كثير من الناس. ومن هذا الصنف الذين ينطق بالثناءِ عليهم الشعراء
والخطباء ومخلدو الكتب، أَعني المؤرخين. فإِن هؤلاءِ الثلاثة الأَصناف هم
الذين ينطقون بالمدح والثناء. والصنف أَيضا من الناس الذين لا يكترثون
بالخيرات التي فيها غيرهم، ولا يلأسفون عليها لأَن عندهم: إِما جميع
الخيرات التي يؤسف على فقدها، وإِما أَعظم الخيرات وأَجلها قدراً، فقد
يأسف المرءُ أَلا يكون في مثل أَحوال هؤلاءِ؛ لأَن الاكتراث ضد الأَسف،
والذي لا يكترث ضد الذي يأسف. والذين يأسفون هم الناس الذين تكون لهم
الشرور المضادة للخيرات التي يكون عنها الأَسف. ومن هنا يبين عدم الاكتراث
الذي هو ضد الأَسف، ومَن الذي لا يكترث له. فإِنه لا يكترث أَحد بأَحوال
الناس الأَسفين. ومن الناس الذين لا يكترث بهم ذوو الجَد، أَعني السعداء،
إِذا كان لهم الجَد خلواً من الفضائل التي تستحق الخير الذي نالهم
بالاتفاق، فإِن الناس يستخفون بأَمثال هؤلاءِ ولا يكترثون بأَحوالهم.
القول في الخلقيات
قال: أَما الأَحوال التي إِذا وجدت في الناس اعترتهم الانفعالات بها وهي التي يكون المرءُ بها مستعدا وهي التي يتوطَّأُ بها لقبول الانفعال والأَشياءُ التي يكون عنها الانفعال أَو زوال الانفعال والسلو عنه وهي التي منها تعمل المقاييس الانفعالية فقد قيل في ذلك في هذه المقالة.وأَما الأَشياءُ التي تعمل منها الأَقاويل التصديقية في جنس جنس من الأَجناس الثلاثة، أَعني المشورية والمنافرية والمشاجرية، فقد قيل فيها في المقالة الأُولى.
وقد بقي أَن نقول هاهنا في الأَحوال التي يتبعها خلق خلق من الأَخلاق. فإِن بمعرفة أَي خلق يتبع أَي حال يمكننا أَن نحرك الذي نخاطبه إِلى أَن يتخلق بذلك الخلق، وذلك إِذا أَوهمناه وجود تلك الحال فيه أَو كانت موجودة مثال ذلك أَن كبر النفس يتبعه السخاء. فإِذا أَثبتنا عند إِنسان ما أَنه كبير النفس حركناه إِلى السخاءِ بأَن نؤلف له القول هكذا: إِنه كبير النفس، والكبير النفس يجب أَن يكون سخيا، فإِنه واجب أَن يكون سخيا. وكذلك ما أَشبه هذا.
قال: وهذه الأَحوال وهي التي المقصود منها تعديدها وأَي خلق يتبع واحدا واحدا منها هي خمسة: أَحدها: الانفعالات. والثاني: الهمم. والثالث: الأَسنان. والرابع: الجدود. والخامس: الأَنفس.
وأَعني بالانفعالات مثل الغضب والرحمة، فإِن هذه يتبعها خلق خاص، وبالهمم الأَشياء التي يختارها كل صنف ويؤثرها في حياته سواء كانت صناعة أَو فضيلة أَو لذة ينهمل فيها. فإِن الأَخلاق أَيضا تختلف باختلاف هذه. وأَعني بالأَسنان سن الشباب وسن الإِكتهال وسن الشيخوخة، وذلك أَن لهذه الأَسنان أَخلاقا خاصة بها. وأَعني بالجدود الأَشياء التي تحصل للإِنسان في بدنه ومن خارج بدنه بالاتفاق وذلك مثل الحسب واليسار الشاذ والجَلَد المفرط، وأَعني بالنفوس الفطر المتباينة التي فطر عليها الناس والعادات المختلفة.
القول في أَخلاق الشباب
قال: فإِما الأَحداث وهم الذين جاوزوا اسبوعين من سنهم إِلى نحو
الثلاثة الأَسابيع فمن أَخلاقهم أَنهم يشتهون كل شيء، وهم مسارعون جموحون
إِلى ركوب ما يشتهونه، وأَغلب الشهوات عليهم الشهوات البدنية المنسوبة
إِلى الزهرة. وهم مع ذلك سريع تغيرهم وتقلبهم يشتهون الشيءَ سريعا ويملونه
سريعا. والسبب في اشتهائهم كل شيء أَن آراءَهم مضطربة لم تستقر بعد كل شيء
من المؤثرات في هذه الحياة الدنيا. وليست آراؤهم وهي التي تكون عن بصيرة
ونظر. ومثال ما يصيبهم من شدة الشهوة مع سرعة زوالها مثل العطش الذي يصيب
المرضى فإِنه عطش سريع الزوال إِلا أَنه شديد جدا. وهم مع ذلك سريعو الغضب
منقادون له تقهرهم حدته وسورته، لأَنهم من أَجل حبهم للكرامة لا يصبرون
إِذا استخف بهم مستخف لكن يمتعضون إِذا ظنوا أَنهم يعابون. وهم محبون
للكرامة وأَشد من ذلك للغلبة، وذلك أَن الحداثة تشتاق الفخامة؛ والغلبة
شيء من الفخامة. وهم للكرامة والغلبة أَشد حبا منهم للمال. وإِنما لا
يحبون المال لأَنهم لم يجربوا الفاقة. وهم يصدقون بالقول سريعا لأَنهم لم
ينخدعوا كثيرا. وهم حسنٌ ظنهم، فسيحٌ أَملهم لحرارة طباعهم كالذي يعرض لمن
يشرب الخمر لمكان الحرارة العارضة له عن شربها. ثم لا يخورون ولا ينكلون،
بل يحملون المشقة فيما يهوونه وذلك لقوة حرارتهم. وهم أَكثر ذلك يعيشون
بالأَمل، لأَن الأَمل إِنما هو للزمان المستقبل، والذكر للماضي. والمستقبل
موجود للغلمان أَكثر من الماضي لأَنه في أَول وجودهم، ولذلك يأمنون كثيرا
ولا يذكرون. وهم يسيرٌ اختداعهم واغترارهم وذلك أَن من شأنهم التصديق من
غير دليل أَو بدليل ضعيف. وإِذا غولطوا بالدليل سهلت مغالطتهم. وهم مع
أَنهم من ذوي التأميل شجعان، وذلك أَن الشجعان غضوبون حسنٌ أَملهم. فأَما
حسن الأَمل فيحدث لهم أَلا يجزعوا، وذلك أَن قوة الرجاءِ في الظفر تشجعهم،
وأَحد ما يشجع هو تأميل الخير، وأَما الغضب فيحدث لهم شدة القلب، لأَنه
ليس من أَحد يخاف فيغضب. ومن خلقهم أَن الحياءَ يغلب عليهم لأَنهم لم
يصيروا بعد إِلى أَن يميزوا بين الأَشياءِ التي يجب أَن يستحى منها وبين
التي لا يستحى منها. فهم لاتهامهم أَنفسهم في كل شيء يستحيون من كل شيء
خوفا من أَن يكونوا قد اخطأْوا. وهم يتمسكون بالسنن جدا ويراقبونها،
والسبب في ذلك أَنهم لم يعملوا النظر فيها حتى يتبين لهم ما هو منها عدل
مما ليس بعدل. وهم كبراء الأَنفس. ويظنون أَنهم لا يفتقرون أَبدا، والسبب
في ذلك أَنهم لم يجربوا الضراءَ والضرورة. ويتشوقون أَبداً من أَفعال
كبراءِ النفوس العظائم منها، وذلك من طريق اتساع أَملهم.
ومن أَخلاقهم أَنهم يؤثرون الجميل أَشد من إِيثارهم النافع. وإِنما يؤثرون
من النافع ما كان جميلا. وإِنما كانوا لا يؤثرون النافع لقلة تفكرهم في
العواقب، وإِيثارهم للجميل من أَجل إِيثارهم للفضائل، وإِيثارهم للفضائل
من أَجل إِيثارهم للمدح والذم. وهم محبون لأَصحابهم أَكثر من سائر الناس،
لأَن من تمام اللذة والسرور - إِذا وُجدا - الصحبة ومشاركة الإِخوان. وهم
لا يطلبون النافع في شيء من الأَشياء ولا في الأَصدقاءِ. وخطؤهم في
الأَشياءِ كثير، وأَكثر ما يكون في الأَشياءِ النافعة التي يؤثرها
المشايخ. وأَفعالهم غير محدودة ولا مقدرة، فيحبون جدا ويغضبون جدا،
وبالجملة فيفرطون في كل شيء وذلك لسوءِ تمييزهم العواقب. فإِن الأَفعال
إِنما تكون مقدرة بتمييز العواقب. ويظنون أَنهم يعلمون كل شيء وذلك بسبب
إِغراقهم في كل شيء. ويركبون الظلم مجاهرة والأَشياء التي فيها العيب
والفضيحة، وهذا أَيضا لجسارتهم وإِفراطهم في الأَشياءِ. وهم رحماءُ لأضنهم
يظنون بالناس جميعا أَنهم خيار صلحاءُ. وهم لقلة شرهم يبغضون أَهل الشر
لأَنهم يظنون أَن أَهل الشر يفعلون ما لا ينبغي. وهم محبون للهزل و المزح.
وانصرافهم عن الشيءِ سريع، لأَن سرعة الانصراف من ضعف الروية. فهذه هي
أَخلاق الغلمان.
في أَخلاق المشايخ
وأَما الشيوخ الذين تجاوزوا سن الكهولة فهم على كثير من أَضداد أَخلاق الشباب، أَعني الأَخلاق السخيفة والشكسة. وأَعني بالسخيفة المنسوبة إِلى الضعف من محبة الهزل والمزاح وتشوق الشهوات البدنية والرحمة للناس والانخداع؛ وأَعني بالشكاسة الأَخلاق المنسوبة إِلى القوة مثل سرعة الغضب والجرأَة ومحبة الكرامة والغلبة وامتداد الأَمل وكبر النفس وركوب الظلم وسائر هذا النوع. وإِنما كان الشيوخ على ضد هذه الأَخلاق، لأَنهم عاشوا دهرا طويلا فقصر أَملهم، واختدعوا كثيرا وأَخطأُوا كثيرا، فساء ظنهم بالناس لوقوعهم على أَسباب الخدع والخطأ بالتجارب. وأَكثر الأَفعال الواقعة بهم كانت كلها شروراً أَو مفضية إِلى الشر. ومن أَخلاقهم أَنهم لا يشكون في الشيءِ فيما بينهم وبين أَنفسهم ولا يتعجبون من شيء ورد عليهم ولا يستعظمونه، لأَنه قد تكرر عليهم. وهم مع أَنهم قد جربوا كل شيء كأَنهم لا يعرفون شيئا. ولا يكترثون بالحمد والذم، لأَن قصدهم الحقائق، مع أَنهم لا يستطيعون شيئا. ومن شيمهم أَنهم لا يحزمون على شيء أَلبتة ولا يقطعون عليه بل يقرنون بكلامهم أَبداً (عسى) و( لعل)، وذلك لكثرة خطأهم ولكثرة ما جربوا من إِخفاق آمالهم. وهم سيئة أَخلاقهم لسوء ظنهم بكل شيء. وسوء ظنهم لقلة تصديقهم؛ وقلة تصديقهم لكثرة تجاربهم. ومن شيمهم أَنهم لا يحبون جدا ولا يبغضون جدا ولا يظهرون ذلك إِلا بالكُره وعند الاضطرار، أَعني الحب والبغض. والحبيب والبغيض عندهم كأَنه في صورة واحدة لدهائهم، وذلك للأُمور التي قيلت من أَنهم عاشوا دهرا طويلا واختدعوا كثيرا وأَخطأُوا كثيرا وأَشباه ذلك. وهم صغيرةٌ أَنفسهم متهاونون بالأَشياءِ العظام لا يشتاقون إِلى شيء سوى ما فيه المعاش. وهم غير ذوي منحة وتكرم، لأَن متاع الدنيا من الأَشياءِ التي بهم إِليها ضرورة، وأَعني بمتاع الدنيا الأَشياء الضرورية في هذه الحياة. وإِنما صار لهم ذلك لكثرة التجربة. وأَيضا فإِنهم يرون أَن الاقتناءَ عسير والتلف يسير، فهم لهذين الشيئين بخلاء، أَعني لوقوفهم بالتجربة على أَن الأَشياء النافعة في هذه الحياة بهم ضرورة إِليها، وبخاصة لضعف أَبدانهم، ولوقوفهم بها على أَن الاقتناءَ عسير، وبخاصة في سن الشيخوخة، وأَن التلف يسير. وهم يسبقون، فيخبرون بما هو كائن لمعرفتهم بالعواقب. ولهذا كانوا جبناء وهم في هذا على خلاف ما عليه الأَحداث لأَنهم ذوو برودة في أَمزجتهم وفتور، والفتيان ذوو حرارة وتوقد. والشيخوخة تؤدي إِلى الجبن لأَن الخوف والجبن تابع للبرد. وهم محبون للحياة لا سيما عند آخر أَعمارهم. وحبهم للحياة ليس هو ليتمتعوا من الشهوات فيها، بل لأَن يحيوها فقط، لأَن أَسباب الشهوات قد عدموها، اللهم إِلا شهوة الطعام من بين شهوات سائر الحواس فإِنها توجد فيهم كثيرة. لأَن الطعام ضروري لهم، فيجتمع لهم مع اللذة به الضرورة. وهم محبون لأَخيار الملوك وعدول السلاطين لصغر أَنفسهم الذي السببُ فيه ضعفُ نفوسهم. وعشرتهم للناس وقصدهم إِنما هو نحو النافع لا نحو الحسن، لأَنهم محبون لأَنفسهم. والنافع هو الشيءُ الذي هو خير للمرءِ في نفسه؛ والحسن هو ما هو خير للغير. وهم قليلٌ حياؤهم. وإِنما كان ذلك كذلك، لأَن إِيثارهم للنافع هو أَكثر من إِيثارهم للجميل. والحياءُ إِنما يكون مخافة فوت الجميل. وتأميلهم يسير لكثرة تجاربهم أَن أَكثر الأَشياء يؤول إِما إِلى الشر، وإِما إِلى ما شره أَكثر من خيره، وإِما لما خيره مساوٍ لشره. وكل هذه الثلاثة الأَقسام غير متشوقة. والأَشياءُ التي هي خير محض، أَو الخير فيها أَغلب، قليلة الوجود، ويحتاج - في ترقب وجودها - إِلى زمان طويل، والذي بقي من أَعمار الشيوخ يسير. وأَكثر عيشهم ولذتهم إِنما هو بالذكر لا بالأَمل، بضد ما عليه الأَمر في الشباب. وذلك أَن الذكر إِنما يكون لما مضى. والشيوخ فقد ذهب أَكثر أَعمارهم. ولهذا تكون منهم جودة التكهن والحدس على ما يكون. وغضبهم سريع حديد لقلة احتمالهم، لكنه ضعيف، لضعف حرارتهم. وشهواتهم منها ما قد انقطع، ومنها ما قد ضعف، فليسوا متحركين نحو الشهوات، لكن نحو النافع. فلذلك قد يظن بهم العفة لانقطاع شهواتهم، وإِنما هم أَعفاء باشتراك الاسم. ويقلقون من طلب الأَفضل وإِنما وُكْدهم الضروري. وأَكثر إِشارتهم بالأَشياءِ التي تحصل الفضيلة
والخلقق الجميل، لا بالأَشياءِ التي تعود على المشار إِليه
بالنافع. ومن خلقهم الظلم، لكن بالمكر والخديعة، لا بركوب الفضائح
والاستهتار كالحال في الشباب. وهم رحماء لكنّ رحمتهم من أَجل ضعفهم وتخيل
سهولة نزول الشر بهم الذي أَشفقوا منه، لا من أَجل حبهم للناس كالحال في
رحمة الشباب. وهم صابرون على الآلام، غير سريع تقلبهم، لأَن الصبر ضد
الهزل الذي هو من أَخلاق الفتيان، ومن أَحب الهزل فليس يحب الجد
والصبر.لجميل، لا بالأَشياءِ التي تعود على المشار إِليه بالنافع. ومن
خلقهم الظلم، لكن بالمكر والخديعة، لا بركوب الفضائح والاستهتار كالحال في
الشباب. وهم رحماء لكنّ رحمتهم من أَجل ضعفهم وتخيل سهولة نزول الشر بهم
الذي أَشفقوا منه، لا من أَجل حبهم للناس كالحال في رحمة الشباب. وهم
صابرون على الآلام، غير سريع تقلبهم، لأَن الصبر ضد الهزل الذي هو من
أَخلاق الفتيان، ومن أَحب الهزل فليس يحب الجد والصبر.
فهذا هو القول في أَخلاق الشباب والمشايخ.
القول في سن الكهول
قال: وأَما الذين هم في عنفوان العمر، وهم الكهول، فمعلوم أَن أَخلاقهم وسط بين هذه الأَخلاق، وأَنهم مجانبون لإِفراط الطرفين. ولذلك هم أَعدل، فليسوا بمتهورين ولا جبناء، ولكن مقدمين على ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وبمقدار ما ينبغي، ولا يصدقون بكل شيء، ولا يكذبون بكل شيء، لكن يتصورون الأُمور على كنهها، ويصدقون بها التصديق التابع لطباعها. وليس عيشهم ولا طلبهم موجه نحو الحسن فقط، ولا نحو النافع فقط، لكن نحو الأَمرين جميعا. ولا هم أَيضا أَهل جد محض، ولا مجون محض، لكن بين ذلك. وكذلك هم في الشهوة والشجاعة، أَعني أَنهم أَعفاء مع شجاعة. والغلمان شجعان شهوانيون والشيوخ جبناء أَعفاء. وجملة القول إِنه قد يحصل لهم الجزءُ النافع من خلق خلق، دون الجزء الضار الموجود في الأَطراف المذمومة الحاصل للشيوخ وللشباب بالطبع. وذلك القدر هو المتوسط. وعلى حسب زيادة أَحد الطرفين في خلق الكهل على الآخر يكون ميله إِلى الشر أَو إِلى الخير، أَعني إِلى الطرف المذموم أَو المحمود. وذلك أَيضا يختلف بحسب الذي يستعمل معه الخلق، قرب حالة تكون زيادة الشجاعة فيها وقربها من التهور آثر من توسط الأَمر في ذلك في حالة أُخرى. فقد يزاد في الشر إِذا احتيج إِلى استعماله مع قوم ما، ويزاد في الخير إِذا احتيج إِلى استعماله مع قوم آخرين.وسن الكهولة هو من خمس وثلاثين إِلى خمسين سنة.
فهذا هو القول في خُلق الأَحداث والشيوخ والكهول.
فصل
ولما كان الكلام الخطبي إِنما يكون أَتم فعلا وأَكثر إِقناعا إِذا رأى المخاطب به أَنه لم يبق فيه موضع فحص ولا تأَمل ولا معارضة إِلا وقد أَتى بها فتزيفت، كان واجبا أَن يكون هنالك فاحص عن القول، ومعارض له غير المتكلم، وهذا إِنما يتم بمناظر وحاكم. أَما فعل المناظر فهو التشكيك على القول المقنع والإِبطال له. وأَما فعل الحاكم فتمييز حجة كل واحد من الفريقين، أَعني المتكلم والمناظر، على مثال ما يوجد الأَمر في الخصومات في المدن. لكن إِذا أُريد أَن يكون القول تام الإِقناع، فواجب أَن يوضع حاكم ومناظر في جميع أَجناس الأَقاويل الخطبية، أَعني المشاورية والمشاجرية والمنافرية.والفرق بين الحاكم والمناظر أَن الحاكم هو أَعلى من المناظر، ولذلك لا يكلف بالدليل على ما حكم به. وأَما المناظر فهو مساوٍ للمتكلم ولذلك لا يكتفى منه برد القول دون أَن يأتى على ذلك بدليل. وربما اكتفى في بعض المدن في الأَقاويل الخصومية بقول الحاكم دون قول المتكلم والمناظر، على ما عليه الأَمر في ملة الإِسلام، فإِنهم إِنما يستعملون في الخصومات قول الحاكم مع الأَشياءِ التي من خارج مثل الشهادات والأَيمان.
والفرق بين الشاهد والحاكم أَن الشاهد يشهد بصدق النتيجة، والحاكم يشهد بصدق القياس المنتج لها، والمناظر يناظر على إِبطالهما. وأَكثر الأَقاويل الخلقية والانفعالية إِنما يستعمل مع الحكام.
فصل
فأَما الخلق الذي يخص سياسة سياسة من السياسات الأَربع التي عددت
فيما سلف فقد ذكرت في باب المشوريات. وينبغي أَن تكون عندنا هاهنا معدة
لنستعملها في الأَقاويل الخلقية. فإِن هنالك إِنما ذكرت لتعمل منها
الضمائر في الأُمور الثلاثة. وإِذ قد تقرر هذا وكان قد تبينت الأَشياءُ
التي منها تعمل الضمائر والتصديقات في الأُمور الثلاثة، أَعني المشاورية
والمنافرية والمشاجرية، فالأَشياءُ التي منها تعمل الأَقاويل الخلقية
والانفعالية، فقد ينبغي أَن نصير إِلى تبيين المقدمات المشتركة التي في
الأَجناس الثلاثة أَعني في المشاورية والمنافرية والمشاجرية. والأُمور
المشتركة التي يطلب تثبيتها في الأَجناس الثلاثة بالمقدمات المشتركة
أَرْبعة أَصناف: الأَول: هل الأَمر ممكن أَو غير ممكن.
والثاني: هل الأَمر مما سيكون ولا بد أَو لا يكون. والفرق بين هذا والممكن
أَن المقدمات المستعملة في الممكن إِنما تستعمل بلفظ الممكن وعلى أَنه ليس
لأَحد الممكنين فضل على الآخر في الوجود. وأَما المقدمات المستعملة في أَن
الشيءَ كائن في المستقبل فإِنما نستعملها في صورة ما هو كائن لا محالة،
وإِن كنا لا نتيقن ذلك، لكن إِنما نستعملها في هذه الصناعة بهذه الجهة.
والثالث: هل الأَمر قد كان في الماضي أَو لم يكن. وما يستعمل من هذا في
هذه الصناعة فإِنما يستعمل في صورة ما قد علم كونه بالتجربة والحس، وإِن
كنا لا نتحقق ذلك.
والرابع: تعظيم الشيء وتصغيره وتفخيمه وتخسيسه، فإِن هذا أَمرٌ عام مستعمل
في الأَجناس الثلاثة. فإِنه إِذا أُشير بالشيءِ أَن يفعله عُظّم، وإِذا
أُشير بالترك صُغّر. وكذلك يفعلون إِذا مدحوا أَو ذموا أَو شكوا أَو
اعتذروا. فإِذا تم القول في هذه، قلنا بعد ذلك في مواد أَصناف الضمائر
وأَصناف المثال، وأَضفنا إِلى ذلك المواضع المشتركة للأَقاويل الخطبية
وغيرها، فإِنا نكون قد أَتينا على الغرض المقصود من هذه الصناعة. فإِنه
إِنما تكلم في المقالة الأُولى في الضمائر من جهة تأليفها لا من جهة
موادها. وهي من جهة تأليفها ممكن أَن تستعمل في الخطابة وغيرها. وإِنما هي
خاصة بالخطابة من جهة موادها.
فنقول: إِنه وإِن كانت هذه الأَربعة المطالب مشتركة للأَجناس الثلاثة،
فإِن بعضها أَخص ببعض وأَولى أَن تنسب إِلى بَعْضٍ. وذلك أَن التعظيم
والتصغير أَخص بالمنافرية التي هي المدح والذم، وأَن الذي قد كان أخص
بالخصومات وكذلك الذي يستعمل كالكائن؛ فإِن الحكومة إِنما تكون في أَمثال
هذه الأَشياء، وأَن الممكن والذي يتوقع كونه أَخص بالمشورية.
وإِذ قد تقرر هذا، فلنقل في المقدمات التي يقنع بها أَن الأَمر ممكن أَو
غير ممكن، ونعني بالممكن وغير الممكن هاهنا ما هو مقدور لنا ومستطاع عليه
مما هو غير مقدور ولا مستطاع عليه، لا الممكن الذي هو في طبائع الأُمور
ممكن، لكن الذي بحسب الإِرادة والاستطاعة. فمنها: إِن كان الشيءُ له ضد،
وكان ضده ممكنا أَن يكون أَو أَن يفعل، فإِن الشيءَ ممكن أَيضا أَن يفعل؛
مثل إِن كان الإِنسان يمكن أَن يصح، فقد يمكن أَيضا أَن يسقم. والعلة في
ذلك أَن القوة والإِمكان للمتضادين واحد.
ومقدمة ثانية: إِن كان الشبيه ممكنا، فالذي يشبهه أَيضا ممكن.
وثالثة: إِن كان الذي هو أَصعب ممكنا، فالذي هو أَيسر ممكن. وإِن كان
الأَمر الذي هو أَفضل وأَحسن ممكنا، فذلك الأَمر - إِذا قيل بإِطلاق -
ممكن، أَعني من غير هذا الشرط. فإِن إِجادة تكوين البيت أَصعب من تكوين
البيت فقط.
ورابعة: إِن كان الذي بدؤه ممكن، فآخره وتمامه ممكن. والإِقناع في هذا
الموضع أَن نقول: لما كان ما لا يمكن كونه مبدئه، فما يمكن كون مبدئه،
يمكن كونه. وقد بين اختلال هذا الموضع في الثانية من الجدل.
وخامسة: وهي ما كان تمامه ممكنا، فمبدؤه ممكن؛ وهو عكس ما قبله.
وسادسة: إِن كان المتأَخر في الطبيعة أَو في الكون - يعني الزمان
فقط - ممكنا، فالمتقدم أَيضا ممكن؛ مثال المتقدم بالطبع: إِن كان الإِنسان
يمكن أَن يكون كهلا، فقد يمكن أَن يكون غلاما. ومثال المتقدم بالزمان فقط
دون الطبع: الصحة الكائنة بعد المرض. فهذا الموضع ينقسم إِلى مقدمتين، ثم
قد تعكس كل واحدة من هاتين، فيحدث هاهنا أَربع مقدمات. فإِنه إِن كان
المتقدم في الطبيعة أَو في الزمان ممكنا فالمتأَخر أَيضا ممكن.
ومقدمة ثامنة: وهي أَن كل ما هو بالطبع محبوب ومشتهى، فهو ممكن أَن يكون
وأَن يفعل؛ فإِنه ليس يشتاق أَحد - إِذا كان شوقه على المجرى الطبيعي - ما
ليس بممكن.
وتاسعة: وهي أَن الأَشياءَ التي تحتوي عليها العلوم والصناعات ممكنة لنا،
أَعني أَن نعلم ما في العلوم وأَن نعمل ما في الصنائع.
وعاشرة:وهي أَن الأُمور التي بدأَ كونها فينا أَو بحكمنا مثل الأَشياء
التي نجبر عليها عبيدنا أَو نتشفع فيها إِلى أَصدقائنا فهي ممكنة؛ وذلك
أَن الذي في ملك الأَصدقاءِ ممكن، كما أَن الذي في ملكنا ممكن.
وحادية عشرة: وهو أَن الذي تكون أَجزاؤه ممكنة، فالكل ممكن.
وثانية عشرة: وهو إِن كان الكل ممكنا، فالأَجزاءُ ممكنة؛ مثال ذلك أَنه
إِن كان البرهان ممكنا، فمقدمات البرهان ممكنة وتأليفه ممكن.
وثالثة عشرة: وهي إِن كان النوع ممكنا، فالجنس ممكن؛ وعكسه وهو إِن كان
الجنس ممكنا، فالنوع ممكن؛ مثال ذلك إِن كان يمكن أَن تكون سفينة ذات
مجاديف كثيرة، فقد يمكن أَن تكون ذات مجاديف ثلاثة؛ وعكسه إِن أَمكن أَن
تكون ذات ثلاثة مجاديف، أَمكن أَن تكون ذات مجاديف كثيرة.
وخامسة عشرة: وهو إِن كان أَحد المضافين ممكنا، فالمضاف الآخر ممكن، كمثل
الضعف والنصف.
وسادسة عشرة: وهو إِن كان شيء ما يمكن أَن يكون لغير ذي صناعة فهو لذوي
الصناعة أَمكن، وذلك أَن هاهنا أَشياء توجد مرة بالعرض، ومرة بالذات، ومرة
بصناعة، ومرة بلا صناعة. فهذه متى كانت ممكنة بالعرض كان إِمكانها بالذات
أَحْرى. وكذلك يوجد الأَمر فيها إِذا وجدت بصناعة وبغير صناعة.
وسابعة عشرة: وهو إِن ما كان ممكنا للأَوضع والأَخس والأَحقر والأَقل
عناية فهو لأَضداد هؤلاءِ أَمكن، كما قال سقراط: إِنه لشديد علىّ أَن
أَعجز عما يفعله الجاهل؛ أَو كما يقال: إِنه لقبيح أَن يعجز أَرسطو عن
معرفة ما أَدكه زينُنْ.
وأَما المقدمات التي يوقف منها على أَن الشيءَ غير ممكن فمعلومة من أَضداد
هذه التي قيلت. مثال ذلك: أَن ما كان غير ممكن للذين هم أَشد عناية فهو
غير ممكن للذين عنايتهم قليلة؛ وأَن الكل إِذا كان غير ممكن، فالأَجزاء
غير ممكنة.
وأَمَّا المقدمات التي يوقف منها على أَن الأَمر كان أَو لم يكن
فيكاد أَن تكون واحدة بالموضوع، اثنتين بالجهة. فمنها: أَنه إِن كان الذي
هو أَقل تهيأ واستعدادا لأَن يكون قد كان، فالذي هو أَكثر تهيأ قد كان.
وموضع ثان: وهو إِن كان المقابل الذي قد جرت العادة أَن يتقدمه مقابله قد
كان، فإِن الآخر قد كان؛ مثال ذلك إِن كان الإِنسان نسي شيئا فقد كان
علمه، وإِن كان حنث، فقد كان حلف. وموضع ثالث: وهو إِن قدر وهوى أَن يفعل،
ولم يكن شيء من خارج يعوقه، فقد فعل. وقريب من هذا إِن كان قدر على شيء
وغضب، فقد كان. والموضع العام لهذين أَنه إِن كان قادرا على الشيءِ، وهو
متشوق له، فقد فعله. وإِنما كان عاما لأَن التشوق يعم الغضب والهوى.
وإِنما صار هذا الموضع مقنعا لأَن الناس أَكثر ذلك يفعلون ما يشتهون إِذا
قدروا، أَما الأَحداث فللنهامة، وأَما الخيار فلشهوتهم للخير. وإِذا كانت
أُمور قريبة الكون متوقعة، فهي كالموجودة وموضع رابع: وهو إِذا كان إِنسان
عادته أَن يوجد منه فعل ما كثيراً، فإِن ذلك الفعل قد كان منه. وموضع
خامس: وهو أَن ننظر إِذا أَردنا أَن نقنع في شيء ما أَنه قد كان هل تقدمته
أَشياء في طباعها أَن تكون قبل ذلك الشيء الذي أَردنا معرفة كونه، فإِن
كانت تلك الأَشياءُ قد تقدمت، حَدَسْنَا أَن ذلك الأَمر قد كان. وهذه
الأَشياءُ السابقة للشيءِ ربما كانت أَسبابا، وربما كانت علامات؛ مثل أَنه
إِن كانت السماءُ برقت، فقد رعدت. وإِن كان الإِنسان قد جرب شيئا ما لينظر
هل يتأَتى له فيه ذلك الفعل أَم لا، فقد كان منه ذلك الفعْل. وموضع سادس
عكس هذا وهو إِذا وجدت الأَشياءُ المتأَخرة عن الشيءِ، فقد وجد الشيء؛
مثال ذلك إِن كانت السماءُ رعدت، فقد برقت؛ وإِن كان فَعَلَ الآن، فقد
ابتدأَ فيما قبل يَفْعَل.
وهذه الأَشياءُ التي تتأَخر عنها أَشياء وتتقدم عليها أَشياء، منها ما هو
باضطرار، ومنها ما هو على الأَكثر. فمثل الاضطراري: إِن كان نسي، فقد علم؛
ومثال الأَكثري: إِن كانت السماءُ رعدت، فقد برقت.
فهذه هي المواضع التي يوقف منها على أَن الأَمر قد كان.
وأَما معرفة أَن الأَمر لم يكن فمن أَضداد هذه بعينها.
وأَما المقدمات التي يوقف منها على أَن الأَمر سيكون وأَنه متوقع كونه،
فهذه هي بأَعيانها. فأَول ذلك إَن كان الأَمر مقدورا عليه ومشتهى، فسيكون.
وأَعني بالمشتهى هاهنا إِما اللذات المحسوسات، وإِما الأَشياء التي يهواها
الإِنسان من غير أَن تكون أُموراً محسوسة، كالمال والكرامة. وكذلك إِن كان
الأَمر مقدوراً عليه مع الغضب أَوْ كان مقدوراً عليه ومختاراً بفكر وروية،
فهو ممكن. وكذلك الأَشياءُ اللازمة للأَفعال الإِرادية ما كان يلزم منها
باضطرار، وما كان لا يلزم باضطرار، فهي كلها معدودة فيما سيكون، إِذا كانت
الأَشياءُ المتقدمة لها. فمثال ما يلزم أَكثريا للفعل الإِرادي خروج السهم
التابع للرمي، ووقوع البصر على الشيءِ التابع لفتح الأَجفان. وأَيضا إِن
تقدمت أَشياء هي متهيئة أَن يكون عنها شيء، فذلك الشيء سيكون؛ مثل أَنه
إِن كانت السماءُ غامت فستمطر. وموضع آخر: إِن كان الشيءُ الذي هو من أَجل
غاية ما موجودا، فإِن الغاية ستوجد؛ ومثال ذلك إِن كان الأَساس قد كان،
فإِن البيت سيكون.
فأَما المواضع التي يوقف منها على الأَعظم والأَصغر والكثير والقليل
والأَفضل والأَخس فهي بأَعيانها التي عددت في باب الأَنفع والآثر في
المشوريات، إِذا جُعلت أَعم قليلا، وذلك بأَن يترقى من باب النافع إِلى
باب الخير. فإِن الخير جنس مشترك للغايات الثلاث من الأَجناس الثلاثة من
أَجناس الأَقاويل الخطبية، وذلك أَنه في المشورية النافع، وفي المنافرية
الحسن، وفي المشاجرية العدل. وبالجملة فمواضع المقايسة تستعمل خاصة وعامة
حتى يمكن أَن تؤخذ مشتركة لجميع المطالب على ما تبن فيه الأَمر في الثانية
من الجدل. إِلا أَن هاهنا إِنما ينتفع بالكليات إِذا طوبق بها الجزئيات،
واستعملت قوة الكُلي فيها، وذلك بأَن يحد كل واحد منهما ويوصف بما يخصه.
فإِن غاية هذه الصناعة إِنما هو التكلم في الجزئيات لا في الكليات، وفيها
تقع مخاطبة الجمهور بعضهم بعضا. وذلك أَنه قد يحتاج في مطابقة الكليات في
المواد إِلى ملكةٍ ودربة، وذلك أَحد ما يتفاضل فيه الخطباءُ.
فقد قيل في الممكن ولا ممكن، وفي أَن الأَمر كان أَو لم يكن، وفي
أَنه يكون أَو لا يكون، وفي التعظيم والتصغير.
وقد بقي علينا القول في الأُمور العامة للتصديقات كلها، وذلك مما لم يستوف
فيه القول في المقالة الأُولى، وأَعني بالتصديقات العامة المقاييس الخطبية
والمواضع الخطبية، فنقول: إِن الأَقاويل الخطبية، كما سلف، جنسان: مثال
وضمير. وأَما الرأي فهو جزء من الضمير. وأَكثر ذلك إِنما يحتاج إِليه في
المشوريات. وسنقول في ذلك. والمثال كما قيل في هذه الصناعة شبيه
بالاستقراء في صناعة الجدل، والضمير شبيه بالقياس فيها. والمثال في هذه
الصناعة نوعان: فأَحدهما: أَن يتمثل المتكلم بأُمور قد كانت ووجدت، مثل
قول القائل: إِنه ينبغي للملك أَلا يغتر فيميز النصحاء من حرسه من غير
النصحاءِ، وإِلا خيف أَن يثبوا عليه فيقتلوه، كما عرض للمتوكل كل من بني
العباس.
النوع الثاني: أَن يكون الخطيب يصنع المثال صنعة ويخترعه اختراعا، وهذا
ربما كان مقدمة، وربما كان حديثا طويلا. والحديث الطويل ربما كان معلوم
الكذب عند التكلم والسامع كالحال في الحكايات الموضوعة في كتاب دمنة
وكليلة، وربما لم يكن معلوم الكذب ككثير من الأَلغاز التي يستعملها أَصحاب
السياسات. واسم المثل والأَمثال أَخص بالمقدمة المخترعة عند أَرسطو،
والمثال أَخص بالموجود منها. والمقدمات التي جرت عادة الجمهور من العرب
وغيرهم أَن يستعملوها في مخاطبتهم، مثل قولهم: ذكرتني الطعن وكنتُ ناسيا،
وقولهم: بلغ الماءُ الزبى، وغير ذلك، هي داخلة في هذا الجنس، إِلا أَن
بعضها مقدمات أَو اخترعها أَول من تكلم بها ليجعلها مثالات عامة لأُمور
كثيرة، وبعضها إِنما نطق بها فقط لموافقة الحال الحاضرة فحفظ ذلك وجعل
مثالا في أَشياء كثيرة، مثل قول القائل: ذكرتني الطعن وكنت ناسيا، فإِن
الحكاية في ذلك مشهورة عن أَول من تكلم بهذا المثل، والسبب في ذلك.
ومثال المثل المخترع الذي إِنما هو مقدمة فقط قول سقراط: إِنه لا ينبغي
أَن يتسلط أُناس بالقرعة، كما لا ينبغي أَن يوضع الصراع قرعةً، أَي يوضع
الصراع بالقرعة. فإِن هذا القول اخترعه سقراط وجعله مثالا لقول القائل:
إِنه لا ينبغي أَن يتسلط ناس بالقرعة، مثل أَن يلزم واحد من أَهل السفينة
أَخذ السكان بالقرعة، فإِن القرعة تصيب أَيهم كان من غير أَن يكون ذلك ممن
يحسن الملاحة.
ومثال الأَقاويل المخترعة قول بعض القدماء لقومه حين أَرادوا أَن
يقيموا من أَنفسهم وأَهل مدينتهم حرساً وجندا لرجل معروف بالتغلب
والاستيلاء والقهر ليقهر لهم عدوهم، فإِنه أَشار عليهم من شر أَعدائهم،
وهو أَن يغلب عليهم ذلك الرجل ويستعبدهم. وضرب لهم مثالا بفرس كان قد
استولى على مرعى وتفرد به، فدخل أُيَّل، فأَفسد المرعى. فلما أَراد الفرس
الانتقام من الأُيَّل، سأَل الإِنسان هل يقدر أَن يعينه على الانتقام منه،
فقال له: نعم إِن أَنت قبلت اللجام وحملتني على ظهرك وفي يدي قضيب. فلما
أَذعن الفرس لذلك وركبه الرجل صار - وكان ما أَمله من الانتقام من من
الأُيَّل - إِلى أَن ملكه الرجل وذلَله وسخره. قال فهكذا فانظروا فإِنكم
إِن قبلتم اللجام، حيث تجعلون ذلكم المتغلب أَميرا مستبدا عليكم وأَقمتم
له الحرس والأَعوان، عرض لكم معه ما عرض للفرس مع الإِنسان. وكتاب دمنة
وكليلة إِنما هو من هذا النوع. وأَرسطو يسمى هذا النوع من الأَخبار
المخترعة كلاما، لأَن المقدمة الواحدة فيه فرقت فجعلت أَشياء كثيرة، ويقول
إِن الكلام إِنما يستعمل لتفهيم الشيء وتلخيصه باستقصاء وذلك يكون بأَخذ
جزئيات الشيء ولوازمه أَكثر مما يكون بأَخذ الشيء جملة ودون تفصيل. ومنفعة
الكلام المخترع أَنه أَسهل من المثال الموجود، لأَن وجود أُمور قد كانت
شبيهة بالأَمر الذي فيه القول يعسر في كثير من المواضع، وأَما الكلام
المخترع فيسهل. وذلك إِنما يكون متى كان المرءُ له قدرة على أَخذ الشبيه
والمشاكل ولوازم الأَشياء والأُمور الكائنة عنها. وهذه القوة هي طريق إِلى
الفلسفة، وذلك لأَن بأَخذ الشبيه يوقف على الكلي. ومنفعة المثال الموجود
أَنه أَقنع عند المشوريات، وذلك أَن المتوقعات أَكثر ذلك، كما يقول
أَرسطو، يشبهن الماضيات. فالأَمثال أَنفع في أَنها أَسهل وفي أَن يكون
الإِنسان يمكنه أَن يجعلها شديدة الشبه بالأُمور التي فيها الكلام.
والأُمور الماضية التي يحتج بها ربما لم تكن شديدة الشبه إِلا أَنها، كما
قلنا، أَشد إِقناعا.
فقد قيل كم أَنواع المثالات وكيف ينبغي أَن تستعمل.
وأَما الرأي فإِنه إِذا عرف ما هو، عرف في أَي الأَشياء ينبغي أَن يستعمل
ومتى يستعمل وفيماذا ينبغي أَن يستعمل وما منفعته.
فنقول: إِن الرأي هو قضية موضوعها أُمور كلية، لا جزئية، وذلك في الأُمور
المؤثرة والمجتنبة، لا في الأُمور النظرية؛ إِذا كانت تلك القضية نتيجة
ضمير، ومبدأ لضمير آخر، من غير أَن يصرح بالقياس المنتج لها، ولا بالمقدمة
الثانية التي تستعمل معها جزء ضمير، ولا بالنتيجة اللازمة عنها. فإِنه
إِذا صرح بمقدمتي القياس المنتج لها، كان القول ضميرا. وكذلك إِذا صرح
بالرأي من حيث هو مبدأ لضمير، وصرح بالنتيجة اللازمة عن ذلك كان القول
أَيضا ضميراً. وذلك أَن القضية الكلية لا تخلو أَن تكون إِما مبدأ ضمير
أَو نتيجة ضمير أَو ما جمع الأمرين جميعا. وذلك هو الرأي إِذا لم يصرح
بالمقدمات المنتجة له ولا بالمقدمة التي تستعمل معه جزء ضمير ولا بالنتيجة
اللازمة عنه من حيث هو مبدأ.
فمثال القضية التي إِذا استعملت نتيجة قياس محذوف كانت رأيا، وإِذا
استعملت مع قياسها كانت ضميرا، قوْل القائل: إِنه ليس الرأي عندي قول من
قال - وإِن كان معلما وذا صيت - إِن كون الغلمان حكماء فضل أَوْ بطالة،
فإِنه إِن أَضاف إِلى هذا القياس المنتج له أَو المبطل لمقابله كان
ضميراً، وذلك مثل أَن يقول القائل: إِن قول من قال إِن كون الغلمان حكماء
فضل أَو بطالة، من أَجل أَنه يكون لحسادهم وحساد آبائهم في بطالتهم موضع
قول، ليس بصحيح. وذلك أَنه يكون للحساد قول من غير البطالة، فليس يلزم من
أَن يكون تعلمهم الحكمة بطالة أَلا يتعلمونها. وإِن لم يات بهذا القول
وإِنما أَتى بالنتيجة وحدها كان رأيا.
ومثال القضية التي إِذا استعملت مبدأ ضمير وحذفت المقدمة الثانية والنتيجة
كانت رأيا، وإِن صرح بالنتيجة كانت ضميراً، قول القائل، إِذا شكى ولده
فقال: إِني لست أَرى في أَولاد هذا الزمان خيرا، فإِن هذا رأَى أَخبر به
أَنه يراه، وإِنما أَراد أَن ولده من أَولد هذا الزمان، وليس في أَولاد
هذا الزمان خير، فولده ليس فيه خير. فإِذا حذفت هذه المقدمة والنتيجة، كان
رأيا.وإِذا صرحت بالنتيجة، كان ضميرا.
وإِذ قد تقرر هذا من أَمر الرأي، فأَنواع الرأي أَربعة: القسم
الأَول: الرأي الذي رفع عنه القياس من حيث هو نتيجة برهان ومبدأ برهان:
وذلك إِنما يكون إِذا كان القياس عليه قريب الظهور بنفسه يلوح للسامع
عندما ينطق ذو الرأي بالرأي ولا يكون شنيعا عند السامع ولا مشكوكا فيه.
وذلك أَنه متى لم يكن بهذه الصورة لم يكن الرأي مقنعا. وهذا القسم ينقسم
قسمين: إِما رأي يلوح قياسه عندما ينطق به للجميع أَو للأَكثر، وإِما رأي
يلوح قياسه للعقلاءِ والأَلباءِ.
والقسم الثاني: من الآراءِ هو الذي يحتاج أَن يردف بالقياس ويشد بالقول،
وذلك إِذا كان الرأي شنيعا أَو مشكوكا فيه خفيا غير ظاهر. وهذا أَيضا
ينقسم قسمين: أَحدهما: أَن يردف بالقياس الذي ينتجه، وذلك إذا كان القياس
بينا بنفسه، وكانت النتيجة غير بينة.
والثاني: أَن يردف بالقياس الذي يكون الرأي جزءَا منه، وذلك بأَن يذكر
الرأي والنتيجة عنه، وذلك إِذا كان الضمير المنتج بينا بنفسه، وكانت
النتيجة غير بينة. فمثال الرأي الذي يرفع عنه القياس ولا يكون جزء قياس
ولا مردفا بقياس مما هو مقبول عند الجميع ظاهر الحجة قول القائل: إِن خير
الأَشياء فيما أَحسب وفيما أَرى أَن يكون المرءُ صحيح البدن. ومثال ما هو
مقبول عند العقلاءِ وظاهر الحجة عندهم قول القائل: إِنه يظهر لي أَنه ليس
محبا مَنْ لم يحب دائما. ومثال الرأي الذي يستعمل جزء ضمير قول القائل:
إِنه لا ينبغي أَن يقبل قول من كان بصفةٍ ما فيما يهم به ويراه. ومثال
الرأي الذي يشد بالضمير المنتج له قول القائل: إِن الرأي عندي للإِنسان
أَلا يجعل غضبه غير ميت إِذ كان هو ميتا.
فقد استبان مما قيل كم أَنواع الرأي وفي أَي موضع يستعمل نوع نوع منها ومع
مَن يستعمل. وذلك أَن الرأي الذي لا يحتاج إِلى ضمير: منه ما يستعمل مع
الجمهور، ومنه ما يستعمل مع الخواص، كما قلنا. والذي يحتاج إِلى ضمير منه
ما يحتاج عند السامع إِذا أُريد أَن يكون مقنعا إِلى ضمير منتج، ومنه ما
يحتاج فيه إِلى التصريح بالنتيجة التي تلزم عنه. والآراءُ إِذا كانت شنيعة
مستغربة فينبغي أَن يقدم قبلها كلام يزيل شُنعتها، مثل قول القائل: أَما
أَنا فإِني - لكي لا أُحسد أَو أُدعى بطالا، أَرى أَنه لا ينبغي أَن
أَتأَدب. وأَما إِذا كانت الآراءُ خفية، فينبغي أَن يقدم قبلها ما يوضحها
ويبينها،والآراءُ يلحقها أَن تكون رموزا وأَشياء مستغربة، وذلك مثل ما
حكاه أَرسطو من المثل الجاري عندهم أَنه لا ينبغي أَن يكونوا شتامين لأَن
لا تكثر الخطاطيف في الأَرض، فإِنه استعمل الخطاطيف مكان الناس الذين
يتكلمون ويقعون في الناس، واستعمل الأَرض مكان الصامتين، فكأَنه قال: إِنه
لا ينبغي لنا أَن نشتم الناس لأَن لا يتبدل الساكتون عنا من الناس فيصيرون
شتامين يطيرون حولنا ويصيحون كما تفعل الخطاطيف.
وصنعة الكلام الرأيى وهو الذي جرت العادة أَن يدل عليه بالأَلفاظ
التي تدل على الوقوف على رأي الرائي مثل قول القائل: الذي عندي، أَو الذي
أَراه، أَو الذي أَحسب، إِنما يليق من الأَسنان بالشيوخ وذلك فيما جربوا
وخبروا من الأُمور. فأَما من لم تكن هذه حاله فليس يحسن ذلك منه. وكذلك
صنعة الأَمثال إِنما تليق بالشيوخ المجربين. فإِن تكلف المرء القول، كما
يقول أَرسطو، فيما لم يجرب جهل وسوءُ أَدب. وينبغي أَن تكون العلامة
المستعملة في الآراءِ كلية، مثل قول القائل: إِن القرويين مختلطة أَوهامهم
لأَنهم يبذلون ما عندهم سريعا، والمختلطة أَوهامهم يبذلون ما عندهم سريعا.
فإِن هذه العلامة في الشكل الثالث، ومقدماتها كلية. فإِن لم يستطع المشير
أَن يأتي بالرأي كليا، فينبغي أَن يأتي به أَكثريا. فإِن لم يمكنه أَتى به
على أَنه لأَكثر من واحد، وأَخذه مهملا، وأَوهم فيه الكلية، وإِن كان ذلك
باستكراه. وهذا قد يستعمل في العلامات التي في الشكل الثالث. فإِن هناك
إِنما تلزم نتيجة جزئية فتوهم أَنها كلية. وينبغي أَن يستعمل عند الإِشارة
بالآراءِ الأَمثال المشهورة، مثل قول القائل: وَلِيَ حارها من تولى قارها،
وقد تبين الصبح لذي عينين. فإِن هذه الأَمثال هي في أَنفسها آراء، وهي مع
هذا شهادات. وينبغي أَن تستعمل الأَشياءُ المنافرة للكل والملائمة على جهة
الرأي، أَعني الأَقاويل التي تلذ النفس أَو التي تؤلمها وتؤذيها، وهي
المعظمة أَو المخسسة كما يقال: اعرف قدرك، مرة على جهة التوبيخ، ومرة على
جهة التعظيم. وكما يقول القائل: ليس يسوءُ منك شيء وقد عرفت خلقك، فإِن
هذا يحتمل المدح والذم.فإِن أَمثال هذه الأَقاويل إِذا استعملت على جهة
الرأي كانت أَوقع، كما لو قال القائل لمن أَغضب بأَن نقل عنه شيء ما: إِن
هذا كذب على قدر علمي. فإِن مثل هذا القول يزيل غضبه. وهو أَنجح إِذا
استعمل على هذه الجهة، أَعني على جهة الرأي.
والكلام الخلقي إِذا استعمل على جهة الرأي كان أَنجع. والذي يلائم من
الخلقيات هو الكلام الذي يليق في الفضائل، كما يقال إِنه ليس ينبغي أَن
يحب بقدر ما يبغض، يعني أَن الحب ينبغي أَن يكون أَكثر، بل بالحري أَن
يبغض بقدر ما يحب. وينبغي أَن يكون ما يخاطب به من الأَقاويل الخلقية بحسب
همة السامع، وبحسب ما يستحسن من الخلق، ويكون كامنا فيه بالقوة. فإِن بهذا
يكون القول أَنجع، لأَنه يصير ما بالقوة في نفسه سريعا إِلى الفعل. مثل
أَن يرى شيخا يفعل فعل صبي فيقول له: هذا غير لائق بالمشايخ، بل اللائق
بهم كذا وكذا. فإِنه إِذا ورد هذا القول على من في نفسه همة ذك الخلق تحرك
إِليه. فإِن لم يمكن أَن يكون من يخاطبه بالكلام الخلقي ممن فيه همة ذلك
الخلق، فينبغي أَن يردف القول الخلقي بالضمير المقنع، مثال ذلك قول
القائل: إِنه ليس ينبغي عندي للإِنسان أَن تكون محبته يسيرة بقدر بغضته،
كما يقول قوم، بل يجب أَن يكون دائم المحبة، فإِن ذلك المذهب إِنما هو
للغدار أَو المكار. فإِن هذا المثال قد جمع تحسين الخلق الذي وصفه وتقبيح
ضده مع ذكر الضمير المقنع في ذلك. أَو مثل أَن يقول هكذا ليس هذا القول
عندي بحسن، أَعني أَن يحب الإِنسان يسيرا بقدر ما يبغض، لأَنه يحق على
المحب أَن تكون محبته دائمة شديدة، لأَنه ينبغي أَن يبغض الشر بغضا شديدا.
فإِنه إِذا استعمل هذا على هذه الجهة جمع ثلاثة أَشياء: أَن يكون رأيا
وضميرا وخلقيا. أَما كونه رأيا فلما استعمل فيه من اللفظ، الدال على
الرأي، أَعني قوله عندي، وأَما كونه خلقيا فلأَنه يحرك إِلى خلق المحبة،
وأَما مقدمة الضمير المستعملة فيه فإِنها مأخوذة من موضع الضد، لأَنه إِن
كان ينبغي أَن يبغض الشرار بغضا شديدا، فقد ينبغي أَن يحب الخيار حبا
شديدا. وأَنجح ما يكون الكلام الخلقي إِذا جمع هذه الثلاثة. واستعمال
الكلام على جهة الرأي فيه منافع: أَحدها أَن الجمهور معارفهم وظنونهم
إِنما هي في الأُمور الجزئية، وذلك أَنه ليس يمكنهم أَن يحددوا في
أَذهانهم الأُمور الكلية، بل إِنما يتخيلونها مع الجزئيات، فإِذا خوطبوا
بالكلي في تلك الجزئيات التي أَدركوها فرحوا بما استفادوا في تلك الأُمور
الجزئية من الكلية. والناس محبون بالطبع للفوائد. فهذا أَحد ما يحر ك به
الكلام الرأيي.
ومنفعة أُخرى أَيضا وذلك أَن كل إِنسان قد تكون له أُمور يؤثرها
ويهواها وأُمور لا يهواها، فمتى خوطب فيما لا يهواه بالكلي، المشترك بينه
وبين ما يهواه، سارع إِلى قبول الكلي وذلك من أَجل أَن فيه حاجته فيتم
الغرض من إِقناعه في ذلك الشيء؛ ولو أَتى به جزئيا لم يقبله ولم يقع له
فيه إِقناع. مثال ذلك أَن من كان له جيران سوء أَو أَولاد فساق فقد يقبل
قول القائل: إِنه ليس في العالم أَشر من الجيران ولا من الأَولاد.
ومن منافعه ما جرت العادة به من حذف القياس المتبت له لظهوره وأَنه مما
يقدر أَن يأتى به كل أَحد من عند نفسه فيجعل السامع أَن يتصور في نفسه
أَنه من ذوي التمييز والمعرفة بقياسه، فيكون ذلك سببا إِلى أَن يصدق به
وينقاد له.
ومن منافعه أَيضا أَن الإِنسان إِذا خوطب في شيء ما ربما تلقى القول في
ذلك بالرد، ويرى أَنه قبيح أَن يذعن لقول غيره، ولما طبعت عليه النفوس من
النفوس واللجاج. فإِذا خوطب في كلي ذلك الشيءِ، بدل الشيءِ، كان أَمكن
أَلا يرد القول فيه وأَن يقبله إِذ يخفى عليه ذلك الشيء الذي كان المقصود
في التخاطب.
والمنفعة الخامسة وهي أَملك من هذه كلها وأَفضل أَن الرأي يجعل الكلام
خلقيا. وإِنما يكون الكلام خلقيا بالرأي، لأَن الرأي إِنما هو قضية كلية
في أُمور تؤثر أَو تجتنب.
والقضية الكلية في الأُمور أَنفسها أَو يتجنبها. فلذلك كان الرأي لذيذا
عند السامع وعند المخاطب. وقد كان يكون الرأي نفسه خلقيا لو انفرد دون
مادته، أَعني دون الأُمور المؤثرة والمجتنبة. فإِن الرأي نفسه يقود المرء
إِلى أَن يتخلق بخلق من يرى ذلك الرأي، فكيف إِذا اقترن بالأُمور التي
تقود الإِنسان إِلى أَن يتخلق بخلق من يؤثر تلك الأُمور، وهي، كما يقول
أَرسطو، الأَشياء التي تركن إِليها المشيئة والضمير، يعني التي تركن
إِليها الإِرادات والنفوس، وهي التي يحب الإِنسان أَن تكون له أَو فيه أَو
يعرف بها ويشهر.
فقد قيل ما هو الرأي وكم أَنواعه وإِنها أَربعة ومِن أَي الأَشياء يعمل
القول الرأيي وما نسبة الرأي إِلى الأُمور وإِنه يستعمل كليا وبالأَكثر
وإِنه يستعمل على جهة الأَشياء الخلقية ويستعمل أَمثالا وقيل أَيضا في
منافعه وفي مَنْ يستعمله.
وينبغي بعد هذا أَن نقول في مواد الضمائر، وبأَي أَحوال يجب أَن تستعمل،
ثم يقال بعد هذا في المواضع. فأَما الضمير قياس ما فقد قيل فيما تقدم
وبُين أَي نحو هو من القياس.
وأَما مقدمات الضمائر فينبغي أَن لا تكون من الأَشياءِ المشهورة جدا بخلاف
ما عليه الأَمر في المقدمات الجدلية، فإِنها كلما كانت أَشهر هنالك كانت
أَفضل، ولا أَيضا من الأٌمور الخفية التي تحتاج إِلى بيان، بل يجب أَن
تكون من المتوسطات بين هذين الصنفين، وهي المقدمات التي ليست تكون بالفعل
عند السامع ويقع له التصديق بها، وذلك أَن تلك لشهرتها فكأَن المتكلم بها
لم يفدْ شيئا لم يكن عند السامع، والغامضة أَيضا تبعد أَذهان الجمهور عن
قبولها. والذين لا أَدب لهم إِنما يتكلمون في المحافل ويسرعون إِلى النطق
بأَمثال هذه المقدمات لأَنهم يظنون في المشهورة أَنها ليست عند السامعين
وذلك لقلة حنكتهم ويظنون بما كان بينا عندهم أَنه بيَّن عند الجميع.
فهذه هي أَصناف المقدمات المذمومة في الضمائر.
والصنف الثالث من المقدمات التي يستعملها غير ذوي الحنكة هي
أَيضا المقدمات التي تحتاج إِلى بيان يسير. فذوو الحنكة يسكتون عن أَمثال
هذه المقدمات ولا يبادرون إِلى التكلم كما يصنع الأَحداث. وبالجملة فليس
ينبغي أَن تكون المقدمات في هذه الصناعة من كل ما يعلمه الجمهور ويرونه،
بل من أُمور معلومة محصلة إِما عند الحكام وإِما عند المقبولين من الناس
عند الجمهور وإِما عند المقبولين عند الحكام وهم الذين ارتضوهم وذلك بأَن
تكون المقدمات بينة لكل هؤلاءِ المقبولين أَو لأَكثرهم وكذلك لكل الحكام
أَو لأَكثرهم. وينبغي أَن تؤخذ مقدمات الضمائر ليس كلها من الأُمور
الاضطرارية، لكن من الممكنة على الأَكثر؛ فإِنه قد يستعمل في الخطابة
مقدمات ضرورية لها معونة في أَشياء ليست ضرورية. وينبغي أَن يعرف المتكلم
الأَمر الذي يريد أَن يتكلم فيه ويقيس عليه، إِما في الأُمور المشورية
وإِما في غيرها من الأَبواب الضرورية للناس، يعني المنافرية أَو
المشاجرية، وذلك بأَن يكون قد أَحاط علما بجنس ذلك الشيء الذي فيه يريد
أَن يتكلم أَو بالشيء الذي يريد أَن يكلم فيه من ذلك الجنس. فإِنه إِن لم
يكن عنده علم من ذلك الشيء، لم يقدر أَن يقنع فيه. وكيف نستطيع أَن نشير
على أُناس بالمحاربة ونحن لا نعرف جندهم ما هم، أَعني أَخيلا هم أَم
رَجَّالة أَم أَصحاب قسي أَم رماح أَم سيوف، ولا كم مبلغ عددهم، ولا مَنْ
إِخوانهم، ولا مَنْ أَعداؤهم، ولا أَية حروب حاربوا ولا مَنْ حاربوا وكيف
حاربوا، فنعلم مقدار جرأَتهم وصدقهم في الحرب. أَو كيف نستطيع أَيضا أَن
نمدح قوماً لا نعلم ما لهم من المكرمات والأَوائل الشريفة، فإِن المدح
إِنما يكون للممدوح بالأُمور الموجودة له مما هي حسنة في نفسها جميلة أَو
يظن بها أَنها حسنة جميلة. وكذلك متى أَخبرنا عن غيرنا بأَنه كان يشير أَو
يمدح أَو يذم أَو يشكو أَو يجيب، فإِنما نخبر عنه بأَنه قد فعل تلك
الأَشياء بأَعيانها التي كنا نحن نفعلها لو تولينا الفعل بأَنفسنا، أَعني
بالأُمور التي هي موجودة للشيءِ الذي يوصف بها بالحسن والقبح في المدح
والذم، أَو يوصف بها بالنفع والضر في الإشارة، أَو بالجور والعدل في
الشكاية. وبهذا الطريق بعينه، أَعني بالأُمور الموجودة للشيءِ، نصف غير
الناس بالجودة والرداءة كما نصف الناس. فإِن هاهنا أَشياء سوى الناس تذم
وتمدح. وبالجملة: إِنما نصف ذوي الخير والشر بالأَفعال التي هي موجودة
عندهم من جهة ما هو ذوو خير أَو شر لا بأَي شيء اتفق، ولكن من التي هي
خاصة بالشيءِ الذي فيه الكلام. وكذلك كل شيء من الأَشياءِ يقنع فيه بقول
قياسي، كان القول القياسي ضعيفا أَو قويا.
والقياس يفضل القياس إِذا كانت مقدماته أَعرف، ولزوم أَجزاء مقدماته بعضها
لبعض أَكثر والحدود الوسطى فيه أَخص بالشيءِ الذي يقصد إِثباته. فهو بين
أَن مقدمات الضمائر ليس ينبغي أَن تؤخذ من أَي شيء اتفق، ولا كيفما اتفق،
بل ينبغي أَن تؤخذ بالشروط التي قيلت والحدود التي وضعت مثل أَن تكون من
الأُمور الموجودة للشيءِ الذي فيه القول وأَن تكون مقبولة عند الخواص من
الناس والمشهورين، وذلك في صنفي المقدمات، أَعني الممكنة والوجودية، وسائر
الشروط التي قيلت. وكل ما كانت المقدمات من أُمور هي موجودة، أَي صادقة،
وكانت أَخص بالشيءِ، كانت أَقنع مما هو أَكثر عموما وأَقل صدقا. والمقدمات
العامة هي الموجودة لأَشياء كثيرة. مثال ذلك أَن يمدح مادح أَرسطو بأَنه
كان حكيما، فإِن هذا شيء يعم أَرسطو وغيره من الحكماءِ. وأَما الذي يخصه
فمثل أَن يقال فيه أَنه الذي كمل الحكمة وتممها.
فهذا هو القول في شروط مقدمات الضمائر.
وقد ينبغي أَن نقول أَيضا في المواضع التي منها نستنبط الضمائر.
والمواضع بالجملة هي اسطقسات الضمائر. فإِنه إِنما يمكننا أَن نصادف
مقدمات الضمائر بطريق صناعي بمعرفة المواضع، وهي أَول شيء ينبغي أَن يكون
عندنا من أَحوال المقدمات. فإِن المواضع بالجملة إِنما هي صفات للمقدمات
وأَحوال لها عامة يُتطَّرق منها إِلى وجود المقدمات. والذي سلف القول فيه
من أَحوال المقدمات هي أَيضا صفات أَخص من المواضع. والمواضع منقسمة
أَولاً بانقسام الضمائر. والضمائر أَولاً صنفان: مثبت وموبخ، كالحال في
القياسات الجدلية. والضمير المثبت هو القياس الذي ينتج أَن الشيءَ موجود
أَو غير موجود من المقدمات المعترف بها. والضمير الموبخ هو الذي ينتج
الشيءَ من المقدمات المجحودة المستنكرات، مثل قول القائل: إِن كذا ليس
بنافع، لأَنه لو كان نافعا لكان أَول من بادر إِليه المشير. وذلك أَنه قد
يترك المشير شيئا تركُهُ مستنكر. فإِذا وفينا المواضع بحسب هذين النوعين
من أَنواع الضمائر، وكانت عندنا عتيدة، كنا قريبين من أَن تحصل عندنا
بالفعل جميع المقدمات الجزئية النافعة في شيء شيء من الأُمور الجزئية التي
قلنا إِن أَحد شروطنا أَن تكون مقبولة عند طائفة طائفة. ومن هذه المواضع
يؤتى بالضمائر في المشوريات التي هي في الضار والنافع، وفي المنافرية التي
هي في المدح والذم، وفي المشاجرية التي هي في العدل والجور، وفي
الانفعالات، وفي الخلقيات. فنقول: إِن المواضع لما كانت ثلاثة أَصناف:
إِما موضع مثبت وإِما موبخ وإِما سوفسطائي، فقد ينبغي لنا أَن نذكر صنفا
صنفا من هذه على حدته، ثم نصير بعد ذلك إِلى القول في المناقضات
والمقاومات ومِنْ أَين ينبغي أَن يؤتى بالضمائر فيها.
فأَحد المواضع المثبتة المأخوذة من الأَضداد وذلك أَنه ينبغي أَن ننظر هل
ضد المحمول موجود لضد الموضوع، فإِن وجد، حكمنا أَن المحمول موجود له.
وإِن أَلفيناه مسلوبا عنه، حكمنا أَن المحمول مسلوب من الموضوع. مثال ذلك
إِن كانت العفة نافعة فالشره ضار؛ وإِن كانت الحرب هي علة الشرور الحاضرة،
فالسلم ينبغي أَن يصلح ذلك ويدفعه.
وموضع من التصاريف والنظائر التي ذكرت في طوبيقى؛ فإِن النظائر والتصاريف
يجب أَن يكون حكمها فيما يوجب أَو يسلب واحدا، وذلك أَنه إِن كانت العفة
خيرا، فالعفيف خيّر.
وموضع ثالث من المضاف: فإِنه إِن كان الفعل حسنا وعدلا، فالانفعال أَيضا
حسن وعدل، مثال ذلك أَنه إِن كان البيع حسنا، فالابتياع حسن. وقد يغلط في
هذا ويظن أَنه إِن كان بعدل وقع الفعل بالمنفعل فبعدل انفعل المنفعل، أَو
بالعكس. والاختلال فيه أَنه إِذا حكم على إِنسانٍ ما بالموت لأَنه قتل
زيدا فجعل لأَوليائه أَن يقتلوه، فيجيءُ آخر فيقتله ممن ليس له بولي، ثم
يعتذر بأَن يقول: إِن كان الموت الذي حل به عدلا، فقتلي له عدل. وهو بحسب
الشريعة ليس بعدل. فلذلك ينبغي أَن ننظر إِلى الشيئين الذين أَخذا من
المضاف هل أَخذا من جهة واحدة أَو من جهتين، ويستعمل النافع في الإِقناع
من ذلك. وذلك أَنه قد يكون مقنعا أَن المضافين يلحقهما شيءٌ واحد، وذلك
إِذا أَخذا من جهة واحدة. وبالعكس يكون أَيضا مقنعا أَن المضافين يلحقهما
شيءٌ مختلف إِذا أَخذا من جهتين. فينبغي للخطيب أَن يتحرى النافع من ذلك
في موضع موضع.
وموضع رابع من الأَقل والأَكثر، كما يقال إِن الذي يضرب أَبويه يضرب
أَقاربه. وذلك أَنه إِذا كان الأَقل وجودا موجودا، فالأَكثر وجودا موجود
ضرورة. وذلك أَن ضرب الأَبوين أَقل وجودا من ضرب القرابة. وأَما في
الإِبطال فعكس هذا، أَعني أَنه إِذا لم يوجد الأَكثر فالأَقل غير موجود.
وذلك أَنه إِذا لم يضرب القرابة، فأَحرى ألا يضرب الآباء. فإِذا استعمل
هذا الموضع في الإِثبات انتقل فيه من الأَقل إِلى الأَكثر، وإِذا استعمل
في الإِبطال انتقل فيه من الأَكثر إِلى الأَقل.
وموضع آخر خاص بالخطابة وهو يشتمل على مواضع وليس يوجد قول
يشملها إِلا أَنه بالجملة يقتضي تبكيت المخاطب بما قد فعله أَو بما هو
فاعل أَو بأَمر ما لم يفعله ولا هو فاعله. فمنها أَن تكلف من سأَلك شيئا
ما يعسر عليك أَن يفعل هو ما يعسر عليه أَو لا يقدر على فعله. ومنها أَن
تسأَل غيرك أَن تفعل ما تعلم أَنه لا يقدر عليه وما ليس له ليظن بك أَنك
ممن له ذلك الشيء. ومنها أَن تعيب على غيرك شيئا تعلمه من نفسك ليظن أَن
الذي تعيب به غيرك ليس هو لك. وذلك أَن ما يعيب الرجل به غيره يظن به أَنه
يتجنبه. إِذ كان ما يتجنبه يعيب به غيره فيظن بهذا العكس. وكذلك إِذا
أَوجبت لغيرك خيرا ليس هو فيك ليظن أَنه فيك. ومن هذا الجنس: المتجني من
غير جناية. ومنها تتبع زيادة الشرائط في القول حتى يصير حجة، أَو نقصان
الشرائط حتى يصير حجة. ومما يوبخ به الشاكي أَن يبين المشكو أَنه أُسوته
في الشر وأَنه ليس هو أَفضل منه. فإِن التساوي في الشر لا يجعل لإِنسان
على إِنسان آخر موضع شكاية. وذلك أَنه كما أَن التأَسي في الخير يوجب مدح
بعض بعضا، كذلك التأَسي في الشر يزيل ذم بعض بعضا. ومن هذا الموضع أَمر
ازدشير بن بابك الملك حيث قال في كتابه إِن الطاعنين على الملوك بالدين
ينبغي أَن يؤتوا من الدنيا ويوسع عليهم حتى يكون الدين هو الذي يقتلهم
ويريح الملوك منهم.
وموضع آخر مأخوذ من التحديد وهو مشترك بين الصنائع كلها ومعنى الحد هاهنا
كل ما هو مقبول أَنه حد، أَو مظنون أَنه حد، كان ذلك حدا في الحقيقة أَو
رسما أَو إِبدال اسم مكان اسم أَو تعريف الشيء بجنسه. فإِن هذه كلها داخلة
في هذا الباب. وأَخذ مثالات ذلك مما اشتهر لدينا أَمر قريب. وأَرسطو ذكر
في ذلك أَمثلة كانت لقوم مشهورين في زمانه.
وموضع آخر من القسمة وذلك أَن نقسم المحمول أَو الموضوع. فإِن الشيءَ إِذا
أُخذ مجملا قد يرى أَنه مستقيم، وبالجملة أَنه بحال ما. فإِذا قسم ظهر
أَنه بخلاف تلك الحال. كقول القائل: إِن مَنْ ظلم، فإِنما يظلم لإِحدى
ثلاث: إِما لسبب كذا أَو كذا أَو كذا. فأَما الإِثنان فلا يمكن أَن يكونا،
وأَما الثالث فليس تزعمه أَنت.
وموقع آخر مأخوذ من الاستقراءِ الذي سلف. مثال ذلك أَن يقول قائل: إِن
الذي يهمه أَمر إِنسان آخر يتقدم فيشكره في الخير والشر مثل الوالد مع
ولده والصديق مع صديقه، وذلك كما فعل فلان مع فلان، وفلان مع فلان. ومثل
من يريد أَن يهون على آخر أَمر السنة أَو يحث عليها فيقول: إِن فلانا
وفلانا فعل كذا وكذا مما يخالف السنة فلم يضره ذلك بل نمت حاله وزاد
سلطانه، أَو يقول إِن فلانا وفلانا تمسك بالسنة فكان ذلك سببا لدوام
سلطانه واتصال ملكه. وموضع آخر من مواضع التقابل: وهو أَن يحكم على شيء ما
بحكم ما من أَجل أَنه قد حكم به مَنْ سلف إِما في ذلك الشيء بعينه، وإِما
في شبيهه، وإِما في ضده، أَعني أَن الحكم على شيء ما يوجب ضد الحكم على
ضده، ولا سيما إِن كان الذين حكموا هم الكل والجمهور والعلماء معهم أَو
أَكثرهم وكان ذلك الحكم دائما، أَو ما يحكم به الأَكثر أَو الحكماء إِما
جلهم وإِما بعضهم، وكذلك أَيضا إِذا حكم به الذين يظن أَنهم لا يحكمون
بالمتضادات، أَعني بضد الحق أَو بضد الخير أَو بضد النافع أَنهم لا يحكمون
بالمتضادات، أَعني بضد الحق أَو بضد الخير أَو بضد النافع أَو بضد العدل
كالإِله والأَبوين والمعلم. والحكم من هؤلاءِ قد يكون بالقول، وقد يكون
بالفعل، وقد يكون بالطبع، أَعني إِذا لم يكن في طباعهم ذلك الشيء، مثل قول
القائل: إِن الموت شر، هكذا حكم الله، فإِنه ليس بمائت. وأَما مثال ذلك في
الأَبوين والمعلم فظاهر، وذلك إِذا احتج على الإِنسان بأَفعالهما
وأَقوالهما.
وموضع من تقسيم المحمول وهو مشترك للصنائع الثلاث. ومثال ذلك
هاهنا أَن يقول قائل في الإِبطال: كيف يكون فلان مجرحا وأَي خمر شربها،
أَو أَي زنى أَتاه، أَو أَي نفس قتلها، وأَي مال أَكله، وأَي صلاة تركها،
وما أَشبه ذلك. ويقول في الإِثبات: كيف لا يكون فلان عدلا وأَي صلاة
فوتها، أَو أَي زكاة لم يؤدها، أَو أَي منكر عرف أَنه أَتاه. وموضع آخر
أَشبه أَن يكون إِما موضع اللازم الذي ذكره في طوبيقى وإِما جزءاً من موضع
اللازم: وذلك أَن ننظر فيما يعرض للشيء من خير وشر ويلزمه، وبالجملة من
اللوازم المتضادة، وذلك في الأَصناف الثلاثة، أَعني المشورية والمشاجرية
والمنافرية. مثال ذلك أَن يقول قائل: إِن الذي يلزم متعلم الأَدب من الشر
أَن يكون محسوداً، والذي يلزمه من الخير أَن يكون حكيما، فينبغي للمرءِ
أَلا يتأَدب لكي لا يحسد، أَو يتأَدب لكي يكون حكيما. وذلك إِما بأَن
يستعمل في الحث على أَحد المتضادين أَو في التخيير.وهذا الموضع يستعمل في
الممكنات وفي سائر الأَشياءِ، وهو لذيذ بحسب ما فيه من ترتيب المتضادين
أَحدهما عند الآخر.
وموضع آخر: وهو أَنه قد يلحق كل واحد من الضدين أَو المتقابلين بالجملة
متقابلان اثنان، إِما معا، وإِما أَن يلحق كل واحد منهما أَحد الضدين فقط.
فالأَول هو الموضع الذي تقدم، وذلك أَن التأَدب وعدمه يلحق كلَّ واحدٍ
منهما خيرٌ وشرٌ معا. وأَما الذي يلحق كلَّ واحد منهما أَحدُ الشيئين،
فمثال قول القائل: إِن نطقتُ، نطقتُ إِما بالحق وإِما بالكذب. فإِن نطقت
بالكذب أَبغضني الله، وإِن نطقت بالحق أَبغضني الناس. فالواجب السكوت. أَو
يقول: بل الواجب التكلم، لأَنه إِن تكلمتَ بحق أَحبك الله، وإِن تكلمت
بباطل أَحبك الناس. ومن الفرق بين هذا وبين الموضع الأَول: أَن اللازمين
هناك لأَحد الضدين قد لا يكونان متضادين - فإِن الحسد والحكمة غير متضادين
- وقد يمكن أَن يجتمعا في موضع واحد. وأَما اللازمان هنا فليس يمكن
اجتماعهما، وذلك أَن محبة الله هي العدل، ومحبة الناس هي الجور.
وموضع آخر: وهو أَن نعتمد المقدمات المتضادة، أَعني التي يلحق أَحد الضدين
منهما أَن يكون جميلا ومعترفا به في الظاهر و باللسان، وقد يكون الضد
الآخر نافعا ومعترفا به في الباطن والضمير. فإِن الخطيب إِذا تحرى بهذا
الموضع أَمثال هذه المقدمات، أَمكنه أَن يقنع به في الشيءِ وضده، وهو من
العجائب وجودة الحيلة. مثال ذلك أَن يقول قائل يريد أَن يحث على أَجتناب
الخمر: إِنها رجس وإِنها محرمة ومفتاح الآثام. فإِن هذا في الظاهر والجميل
مقر به. ويقول آخر: أَنها تنفع المرءَ في صحته وتجيد خلقه وذهنه، فإِن هذا
معترف به في الضمير.
وموضع آخر مركب من موضعين من مواضع التقابل، أَحدهما تركيب الأَضداد،
والآخر عكس مقدمات الأَضداد، وذلك مثل قول القائل، وقد عذل في استخدام
ابنه وكان طويلا، فقال لهم: إِن كنتم تعدّون الطوال من الغلمان رجالا، فقد
أَوجبتم أَن القصار من الرجال غلمان. فإِن قولنا: " " الغلام الطويل رجلٌ
" " عكس قولنا: " " الرجل القصير غلامٌ " " . والرجل والغلام متقابلان،
والقصير والطويل كذلك.
ومثال آخر من هذا: إِن كنتم لا تجعلون زواركم مقصين ولا مبعدين إِذا فعلوا
الفواحش، فلا تقربوا الأَعفاء ولا تزوروهم.
وموضع آخر: أَن يكون الضدان أَو المتقابلان يلزمهما شيءٌ واحد بعينه، كقول
القائل: إِنه سواءٌ في الإِثم والفرية أَن الإِله مخلوق وأَنه لا يموت،
أَو قوله إِنه ليس بمخلوق وإِنه يموت. فإِن الذي يلزم عن هذين المتقابلين
هو أَمر واحد بعينه وهو أَن يكون الإِله ليس بإِله. ولزوم الشيءِ الواحد
للمتقابلين معا ليس هو بالحقيقة، وإِنما ذلك بالعرض. كما قيل في المسئلة
المشهورة: هل ينبغي أَن يتفلسف أَو لا يتفلسف. فإِنه بأَي الوجهين أَجاب،
لزمه أَن يتفلسف. ومن هذا تبكيت أَفلاطون لأَفروطاغورش. ومن هذا قول
القائل: سواءٌ عصيت الله أَو عصيت الرسول.
وموضع آخر نافع في أَخذ المقدمات المتضادة: وهو أَن هنا أَحوالا
لأَشياء تلحق تلك الأَحوال أَشياء متضادة. فإِذا أَخذت تلك الأَحوال حدودا
وسطى أَمكن أَن يقنع بها في الشيءِ وضده. وهذا الموضع يخالف سائر
المتضادات بأَن هذه الأَحوال ليست متضادة. مثال ذلك أَن يقول القائل: أَما
أَنا عند الخوف فإِني لا أُقاتل بل أَهرب، وذلك أَن بالهرب أَتخلص، وإِذا
أَمنت قاتلت، أَو يقول: بل إِذا خفت قاتلت، فأَنا بالقتال أَتخلص. وإِذا
أَمنت لم أَحتج إِلى القتال.
وموضع تستعمل فيه الأَشياءُ التي تلزم عنها غايات شتى، وهو أَن ننظر في
الأَشياءِ التي إِذا كانت، احتملت غايتين مختلفتين أَو غايات كثيرة، فإِنا
إِذا أَخذنا تلك الأَشياء حدودا وسطى، أَمكننا أَن نقنع بها في الشيءِ
وخلافه. وذلك مثل أَن يقال: إِن فلانا لم يؤدب فلانا لأَن الشرع أَقتضى
تأَديبه، بل لأَنه كان حاقدا عليه. ومثل أَن يقول القائل في شيء دفعه
لغيره: إِنما دفعت لك عارية، ويقول الآخر: إِنما دفعته هبة. وهو موضع
يستعمل في الأَصناف الثلاثة الخطبية.
وموضع آخر عام للذين يختصمون وللذين يشيرون وهو أَن ينظر في الأَشياءِ
التي يرغب فيها وفي الأَشياءِ التي لا يرغب فيها وفي الأُمور التي من
أَجلها يفعل الشيء إِذا وجدت، أَو لا يفعل إِذا عدمت. فمن ذلك إِن كان
الأَمر ممكنا وكان سهلا وكان نافعا له وللأَصدقاء وضارا للأَعداءِ أَو غير
ضار أَو كان الضر فيه أَقل من المنفعة، فالمرغب أَو المحرض ينبغي أَن
يستعمل هذه ونحوها؛ فأَما الذي يصد أَو يكف فأَضداد هذه. ومن هذا يشكو
الشاكون ويجيب المجيبون. أَما الشكاية فمن الذي يرغب، وأَما الاعتذار فمن
الذي يصد. ومن هذا الموضع، فيما قال أرسطو، تؤخذ خطابة رجلين من القدماءِ
مشهورين بالخطابة عندهم.
وينبغي أَن تكون المقدمات التي تستعمل هاهنا من الأَشياءِ المظنونة
المقبولة في بادئ الرأي، لا من الأَشياءِ التي لا يصدق بها إِلا أَن تكون
مما يمكن أَن تقبل ويقع بها الإِقناع من قرب وبسهولة. وذلك أَن الأَشياءَ
التي يقع بها التصديق هاهنا صنفان: أَحدهما ما إِذا سمعه الإِنسان، صدق به
وقبله من ذاته، والآخر ما إِذا سمعه، قبله لشهرته ولأَنه محمود عند الجميع.
والصنف الأَول إِنما يقع له بالتصديق لأَنه يظنه من الثاني، أَعني من
المشهور. فتكون المقدمات المظنونة صنفين: صنف يصدق به لأَنه مشهور، وصنف
يصدق به لأَنه يظن من المشهورات. وذلك أَن التصديقات ثلاثة أَصناف: إِما
يقيني، وإِما مشهور حقيقي، وإِما في بادئ الرأي. فمتى عرى القول الخطبي من
هذين الصنفين ولم يكن مما يقع التصديق به عن قرب لم يَنْبَغ أَن يستعمل في
هذه الصناعة. ومثال ما يقع الإِقناع به عن قرب ما قال بعض القدماءِ: إِن
السُّنة تحتاج إِلى سُنة تقومها، كما يحتاج السمك الذي في البحر إِلى
الملح، والبحر مالح، وكما يحتاج الزيتون إِلى الزيت، وفيه الزيت. فإِن
هذا، وإِن كان غير مقنع، فقد يقع به الإِقناع عن قرب، إِذا زيد فيه أَن
السمك يحتاج إِلى الملح إِذا أُريد بقاؤه بحفظه وأَن يجعل له طعما آخر.
وكذلك يزاد في الزيتون إِذا أُريد بقاؤه وتغيير طعمه، أَعني أَن يجعل
الزيت فيه، وإِلا فما هو المقنع أَن يقال إِن الذي في الملح يحتاج إِلى
والذي في الزيت يحتاج إِلى الزيت عن قرب.
القول في مواضع التوبيخ
فمنها أَن ننظر في الخيرات والشرور التي يذكر بها الخصم بالمدح أَو بالذم مما هو خارج عن ذلك الأَمر الذي فيه القول، وذلك ما كان منها متحدثا به عند الناس وجاريا على أَلسنتهم وأَفواههم، أَو كانوا مستعدين لأَن ينطقوا به، وإِن لم ينطقوا به بعد، أَعني من أَفعال الخصوم وأَقوالهم الماضية والحاضرة، فسيتعلمون توبيخ الخصوم بذلك عندما يلزمونها أَمراً ما، كما قيل: إِنكم قوم تحبون حبا يجمع الاَسم والحد، يريد أَن مودتهم صادقة وأَنها من قلوبهم. وكما قيل: إِنه لم يعط أَحدٌ منكم قط شيئا، وأَما أَنا فقد وهبت للكثير منكم. وبالجملة فليكن النظر هاهنا في كل ما يذكر به المتخاصمان معا مما هو خارج عن المقدمات التي تستعمل في بيان الشيء.وموضع آخر مأخوذ من أَشباه الأَفعال التي يوبخ بها ومن خيالاتها
وأَشباه الخصوم من الناس، وذلك إِذا لم يقدر المشكو به أَن يثبت العلة في
ذلك الأَمر والسبب فيه، أَعني في ارتفاعه عنه حتى يزول قبح ما ذكر به.
فإِنه قد يعتذر المشكو به بأَن شبيه ذلك الفعل قد كان من الشاكي، أَو قد
كان ذلك الفعل بعينه من شبيهه من الناس. وهذا هو التأَسي. وإِنما يفزع
إِليه حيث لا يقدر الخطيب على إِعطاءِ السبب الذي يزيل التهمة عنه.
وموضع آخر أَن يجعل الشيء نفسه هو العلة، وهو في الحقيقة مصادرة، لكن هو
هاهنا مقنع من جهة شهرته، وليس يرى الجمهور فيه أَنه مغالطة. وذلك يكون
بتغيير اللفظ أَو بتبديله، لا بأَن يأتى بذلك اللفظ بعينه، مثل أَن يقول
إِنه موجود أَو إِنه ليس بموجود لأَنه ليس بموجود بل كما قال بعض القدماءِ
حيث نفاه إِنسان عن بلده ونسبه: إِنه في نسبه وبلده كذا، لأَن هذا مكتوب
في رأس المدينة على صومعة هنالك. وذلك أَن العادة كانت عندهم أَن تكتب
أَسماءُ أَهل بيوت المدينة في صوامع مشهورة. وذلك عندنا مثل أَن يقول
القائل: إِن نسب فلان كذا، لأَن به تقع شهادته في العقود.
وموضع آخر من التوبيخ: وذلك إِذا فعل فعلا وترك ما هو أَفضل منه مع
إِبطاله له.
وموضع آخر: أَن ننظر هل يفعل المشير بالأَمر ذلك الشيءَ الذي أَشار به،
إِذا كان ممكنا له فعله. فإِنه إِن لم يفعل ما أَشار به وهو له ممكن كان
فيه موضع توبيخ له. لأَن الذي أَشار به: إِن كان خيرا يكتسب أَو شرا
يجتنب، فليس يختار أَحد ترك فعل الخير أَو اجتناب الشر طوعا. وهذا الموضع
كاذب. فإِنه قد يشير الإِنسان بالشيءِ وهو يظنه في وقتٍ ما يشير به خيرا،
ثم يتبين له أَنه ليس بخير، فلا يفعله، وهو قد كان أَشار به. ومن هذا
عندنا أَن يَرْوى الراوي الحديث ويترك العمل به.
وموضع آخر: وهو أَن ينظر إِلى الفعلين اللذين يفعلهما الإِنسان، هل
أَحدهما يلزم عنه - إِذا فعله - أَلا يفعل معه الآخر، فيكون في ذلك موضع
توبيخ. قال: مثل أَن يبكى على الميت، ويتقرب بالصدقة عنه. فإِن البكاءَ
يدل على موته، والتقرب على حياته.
وموضع آخر: أَن ينظر في الشيءِ الذي يجعل دليلا على الشكاية، فيقيم منه
دليلا - إِذا أَمكن - على الاعتذار، أَو يكون الشيءُ الذي يعتذر به يفهم
منه نفسه دليل على الشكاية. وذلك يكون على وجهين: إِما أَن في طباع الدليل
ذلك، مثل أَن يوجد إِنسان في وسط الدار واقفا، فيقال إِنه لص، لأَنه وجد
في هذا الموضع، فيقول هو: لو كنت لصا، لم أَكن واقفا في وسط الدار.
والوجه الثاني: أَن يوجد في ذلك القول الذي يعتذر به المعتذر أَو يشكو منه
الشاكي موضعٌ يستدل به منه ضد استدلاله. فإِن كان في اعتذار، استدل منه
على الشكاية، وإِن كان في شكاية، استدل منه على الاعتذار. وذلك من خطاء
يعرض في القول من زيادة أَو نقص أَو إِهمال شرط من شروطه. مثل أَن يتهم
إِنسان بأَنه سرق شيئا من منزل اتفق أَن قُتل صاحبه فيه، فيقول: لم أَسرق
منه شيئا، ولا قتلت صاحبه. فإِن في مثل هذا الموضع تتأَكد التهمة عليه،
إِذ كان قد أَخطأَ وزل في أَن أَجاب عن ما لم يُسئل عنه. وقد كان بعض
المشاهير في هذه الصناعة إِنما يؤلف خطبه من هذا الموْضِع.
وموضع آخر تكتسب المقدمات فيه من اسم الشيء. وذلك إِما باشتقاق
وإِما بنقل وإِما باستعارة. مثال ذلك أَن يكون رجل اسمه حديد أَو مقاتل،
فيتفق أَن يكون في نفسه حديدا أَو مقاتلا، فيقول: أَنت حديدٌ، يا حديد؛
وأَنت مقاتلٌ، يامقاتل. وربما كان بنقل الاسم كما هو، وربما كان بتغيير
قليل كما قيل: أَمتك آمنة. وكما قال بعض الملوك لرجل شاعر يعرف بابن فاتك:
أَنت ابن باتك فقال: أَنا ابن بابك. فهذه جملة المواضع التي تشتمل على
التثبيتات والتوبيخات بحسب ما ذكر أَرسطو. والتوبيخات بالجملة أَنجح
وأَنجع من التثبيتات، لأَنها تخيل إِلى السامع مع الشيءِ ضده. فيكون تصوره
أَتم وأَلذ. وأَيضا فإِن الموبخات لقرب بيانها تؤلف من أَلفاظ أَقل، فتكون
أَسهل حفظا وأَسرع إِبانة للشيء. وهما بالجملة متقاربان، لكن الموبخات
أَبين وأَظهر عند السامع، وكلاهما يفعل الاقناع المحرك للنفس لا سيما ما
كان منها إِذا ابتدأَ الخطيب بصنعته أَحس هو والسامعون بالغاية المقصودة
منه. وبالجملة فيقفون منه على الشيء اللازم التالي لصدر القول. فإِن
الضمائر التي بهذه الصفة قد يفرح بها المتكلمون إِذا أَحسوا منها بهذا
المعنى، فضلاً عن السامعين. وهذه المواضع بالجملة إِذا تحصلت للإِنسان
أَمكنه أَد يدرك بها من هذه الصناعة في زمانٍ قصير وتعبٍ يسير ما شأنه أَن
يدرك في زمانٍ طويل وتعبٍ كثير.
ولما كان هاهنا في الصناعتين المتقدمتين، أَعني صناعة البرهان والجدل،
صنفان من القياس: أَحدهما هو قياس بالحقيقة في تلك الصناعة والآخر مموه
يظن به أَنه من مقاييس تلك الصناعة وليس هو من مقاييسها، كذلك الأَمر في
صناعة الخطابة فإِن فيها ما هو ضميرٌ بالحقيقة ومنها ما هو ضمير مموه.
والأَشياءُ التي تفعل ذلك هي التي أُحصيت في كتاب سوفسطيقي، إِلا أَنه
يذكر المشهور منها هاهنا، أَعني المشترك وما هو أَيضا منها خاص بهذه
الصناعة. إِذ كانت القياسات السوفسطائية منها ما هي مشتركة للصنائع كلها
ومنها ما يخص صناعة دون صناعة، وذلك أَنه كما أَنه قد يكون قياس مموه في
صناعة البرهان، ولا يكون في صناعة الجدل، كذلك قد يكون قياس مموه في صناعة
الجدل ويكون هاهنا ضميرا بالحقيقة، مثل قياس العلامة الذي في الشكل الثاني.
والمواضع المغلطة صنفان: أَلفاظ ومعان. فأَما الضمائر المغلطة من قبل
الأَلفاظ فأَحد أَنواعها أَن تكون أَشكال الأَلفاظ واحدة وما تدل عليه
الأَشكال من تلك الأُمور مختلفة. وهذا الموضع هو مبدأ لقياسات كثيرة
مغلطة، مثل قولنا: إِن كان الرجاءُ هو المرجو، فالذهاب هو المذهوب به،
وإِن كان الذهاب فعلا، فالرجاءُ فعل لا مفعول. فإِن هذه إِذا أَلفت على
هذا الوجه حدث منها ضمير مظنون من غير أَن يكون في الحقيقة ضميراً. ومنها
الذي يكون باتفاق الاسم واشتراكه مثل قولنا فيمن نسبه كلبي: هو من كلب،
والكلب خسيس، فهو خسيس. وإِنما غلط في ذلك أَن اسم الكلب يقال على القبيلة
وهذا الحيوان النابح.
وموضع آخر من الكلام المفرد إِذا قيل مؤلفا، ومن المؤلف إِذا قيل مفردا،
لأَنه يظن أَنه شيء واحد. مثال ما يصدق مفردا ويكذب مؤلفا أَن يقال إِن
الذي يعرف حروف المعجم كل واحد على حاله يعرف الشعر، لأَن الشعر مؤلف من
حروف المعجم. ومن هذا الموضع، أَعني من الإِفراد والجمع، عرض ما عرض في
مسائل القول في المواريث، فإِنه لما وضع لكل واحدٍ من الوارثين شريعة في
حظه من المال كان ذلك صادقا، فلما جمع ذلك مع الغير لم يصدق. فإِنه لا
يوجد مال له نصف وثلثان، فاختلف الفقهاء في ذلك. فهذه كلها مواضع
سوفسطائية مشتركة للصنائع الثلاث، أَعني البرهان والجدل والخطابة.
وموضع خاص بالخطابة وهو أَن يُصير القائل السامعين بحيث يشتبه عليهم
الأَمر حتى يقع في نفوسهم أَن المدعى عليه فعل ذلك الأَمر الذي ادعى به
عليه من قبل أَن يثبت المدعى ذلك أَنه فعل ذلك، أَو يقع في نفوسهم أَن
المدعي كاذب في دعواه من قبل أَن يعتذر عنها المدعي عليه. فالأَول يكون
مما يقوله المدعي أَو يفعله، مثل أَن يعظم الذي ادعى به أَو يقلق منه
ويظهر منه تأَذٍ وضجر.
والثاني مما يفعله المدعي عليه أَو يقوله، مثل أَن يبكي أَو يقوم فيلتطم
ويضع التراب على رأسه أَو يقول أَقاويل يذهل بها السامع أَو الحاكم حتى
يتشاغل فيسهو عما يعني به ولا يقدره قدره.
وموضع آخر عام وهو المعروف بموضع اللاحق، مثل قول القائل: فلان
سارق لأَنه شرير، فإِنه يصدق أَن السارق شرير وليس ينعكس، أَعني أَن مكل
شرير سارق.
وموضع آخر مما بالعرض، كما قيل إِن الجرذان أَعانتنا على عدونا، لأَنها
قرضت أَوتار قسيهم.
وموضع آخر وهو أَن يجعل ما ليس بعلة للشيءِ علة له، وذلك بأَن يؤخذ الكائن
مع الشيءِ أَو بعده سببا لوجود الشيء من غير أَن يكون سببا. فإِن الخطباء
يستعملون ما بعد الشيء مكان ما من أَجله يكون الشيء ولا سيما في المشورة،
كما لو قيل إِن تدبير أَبن أَبي عامر كان من أَجل شيء قصده، لأَن الفتنة
بالأَندلس كانت بعده.
وموضع آخر وهو أَن يكون الشيء سبيله أَن يؤخذ بحال ما فيؤخذ بحال أُخرى،
وذلك إِما من زمان أَو مكان أَو جهة أَو حال، أَو يكون مما سبيله أَن يؤخذ
بحال ما فيؤخذ مطلقا. وهذا الموضع مشترك في التغليط لصناعة البرهان والجدل
والخطابة؛ إِلا أَن مواده تختلف في هذه الصنائع الثلاث. فالتغليط به في
الجدل يكون بالأُمور الكاذبة الممكنة، فإِنه إِذا أخذ فيها مطلقا ما ليس
بمطلق بالفعل، فإِنه ممكن أَن يكون مطلقا. والتغليط به في صناعة البرهان
يكون بالمعدومة، وهي الكاذبة الممتنعة. ومواده في الأُمور الخطبية هي
الأُمور الواجبة. وإِنما كان هذا الموضع مقنعا لأَن كثيرا من الأَشياءِ
يصدق جزئيا وكليا، فيظن بكل ما يصدق جزئيا أَنه يصدق كليا. وإِنما يوقف
على كذب هذه المقدمات المطلقة في هذه الصنائع الثلاث، إِذا زيد في القول
شريطة يظهر بها كذب المقدمة المطلقة، مثل أَن يقال فيمن هو عادل في
الأَموال إِنه عادل على الإِطلاق.فإِذا أَظهر أَنه غير عادل في النكاح،
اشترط في الأَموال، فتصح حينئذ المقدمة، ويظهر كذب إِطلاقها.وإِذا كان
الشيء يصدق جملة على الشيءِ إِذا أخذ بحال ما، ويكذب إِذا أخذ بحال أُخرى،
أَمكن إِذا أخذ مطلقا أَن نقنع به في المتقابلات معا، وتنشأ من ذلك
أَقاويل مقبولة متضادة خطبية. مثال ذلك أَن يكون إِنسان ما أَصاب أَمرا
أَوجب عليه حدا من الحدود الشرعية وهو مريض، فإِنه يمكن أَن يقال فيه إِنه
واجب وأَن يقام عليه الحد وإِنه ليس بواجب؛ وذلك أَن من جهة ما جني، فقد
وجب عليه الحد؛ ومن جهة ما هو مريض، فليس واجبا عليه. ومن هذا الموضع يصير
الشيءُ القليل الخسة خسيسا بإِطلاق، ويؤخذ الشيء القليل الشرف على أَنه
شريف بإِطلاق. ويشبه أَن يكون هذا الموضع إِنما هو سوفسطائي بالإِضافة
إِلى صناعة البرهان، وأَما بالإِضافة إِلى صناعة الجدل وهذه الصناعة،
فإِنه جزء منهما. فإِنه من المقنع أَنه إِذا كان الذي ليس موجوداً بإِطلاق
ليس موجودا بحال ما، فمن الواجب أَن يكون ما هو موجود بحال ما موجوداً على
الإِطلاق. وقد ذكر هذا الموضع في المقالة الثانية من كتاب الجدل على أَنه
جزء من تلك الصناعة.
فقد قيل في المواضع التي تعمل منها الضمائر الحقيقية والضمائر المموهة.
وقد بقي أَن نقول في المناقضات التي تتلقى بها الضمائر وهي التي يستعملها
السامع؛ فإِن التي سلف فيها القول إِنما يستعملها المبتدئ بالكلام، فنقول:
إِن النقض بالجملة للقول القياسي يكون على وجهين: إِما بأَن ينقض
شكله بأَن يبين أَنه غير منتج؛ وإِما بأَن تقاوم مقدمات القياس أَو
النتيجة. فأَما مناقضة النتيجة فإِنما يكون بالضمائر المستخرجة من هذه
المواضع؛ لأَن الضمائر إِنما تؤلف من الظنون، والظنون يلحقها أَن تكون في
الشيءِ الواحد متضادة، فينتج عن ذلك أَشياء متضادة، أَعني أَنه يؤلف منها
ضمير ينتج الشيءُ وضمير ينتج مقابله. وهذا أَيضا يلحق في المقدمات
المشهورة في الجدل، بخلاف ما عليه الأَمر في صناعة البرهان. فأَما معاندة
مقدمات القياس فإِنها أَربع، كما قيل في الثامنة من طوبيقى: إِما معاندة
المقدمة التي لزمت عنها النتيجة، وإِما معاندة القول، وإِما أَن تكون
المعاندة بحسب السائل، وإِما أَن تكون من قبل تطويل زمان المناظرة.
والمواضع التي تؤخذ منها معاندة المقدمات هاهنا أَربعة: إِما الأَشياءِ
التي هي موجودة في الشيءِ الذي تقصد معاندته، وذلك مثل الكلي والجزئي،
وإِما من الأُمور التي من خارج، وهذا صنفان: إِما من الضد، وإِما من
الشبيه. والرابع: المقاومة التي تكون بحسب رأي الرجل المشهور المقبول
الحكم، أَعني إِذا كان رأيه مضاداً للمقدمة الموضوعة.
أَما الإِبطال الذي يكون من نفس الأَمر فمثل لَوْ وضَع واضعٌ أَن الرياسة
خير وأَنه أَن يكون المرءُ مرءُوساً خير، فإِنه إِن أَبطلها بالكلية، قال:
كون الإِنسان مرءُوسا يحتاج إِلى غيره، والحاجة شر، فالرياسة شر؛ وإِن
أَبطلها بالجزءِ، قال: ليس كل رياسة نافعة. وذلك أَن التغلب رياسة وليست
خيرا. فهذان هما صنفا الإِبطال الذي يكون من الأَشياءِ الموجودة في الشيءِ
المقصود إِبطاله.
ومثال الإِبطال الذي يكون من الضد أَن تكون المقدمة الموضوعة أَن الرجل
الخير هو الذي يحسن إِلى إِخوانه أَجمعين، فيقاوم ذلك بأَن يقال لَوْ كان
هذا حقا، لكان الشرير هو الذي يسيءُ إِلى إِخوانه، وليس كذلك.
ومثال المقاومة والمعاندة من الشبيه أَن يوضع أَن من لقي آخر بشر فهو
يبغضه، فيقاوم ذلك بأَن يقال: إِن هذا ليس بصادق لأَن مَنْ يلقى آخر بخير
قد لا يحبه. ووجه الشبه في هذا المثال إِنما هو بالمناسبة. وذلك أَن نسبة
البغضة إِلى من يلقى منه شرا نسبة المحبة إِلى من يلقى منه خيرا. وقد جمع
هذا المثال المقاومة من جهتين: من جهة الشبيه ومن جهة الضد. وذلك أَن
المحبة ضد البغضة والشر ضد الخير.
وأَما مثال المقاومة التي تكون بحسب رأْي الحاكم، فذلك موجود كثيرا في
المصالح التي تضادها الشرائع. وأَكثر ما يوجد هذا التضاد بين الشرائع
العامة والخاصة؛ وأَعني بالعامة المشتركة لجميع الأُمم، وأَعني بالخاصة ما
تخص أُمة أُمة.
وإِذ قد تقرر كيف تقاوم المقدمات في الضمائر بالجملة، فلنقل كيف يقاوم
ضمير ضمير من أَصناف الضمائر المستعملة في الخطابة. والضمائر كما قيل
أَربعة: فمنها المسمى الواجب، وهو الضمير الكائن من المحمودات في أَي شكل
كان، ويسمى ما كان من هذه في الشكل الأَول بالأَشبه أَو المشبه. ومنها
المسمى برهانا، وهو الضمير الكائن من العلامات في الشكل الأَول. وإِنما خص
هذا باسم البرهان بحسب أَنها اضطرارية.
والصنف الثالث المسمى علامة وهو المؤتلف من العلامات في الشكل
الثاني. والصنف الرابع المسمى بالرسم وهو مؤتلف من العلامات في الشكل
الثالث. ولما كان الضمير الذي يسمى الواجب وهو المؤتلف من المحمودات في
الأَشكال المنتجة لم يمكن أَن يقاوم من جهة تأليف القياس، بل من جهة
مقدماته. ولما كانت مقدماته محمودة، وكان هذا الصنف إِنما يأتلف فيه
المواد الممكنة على الأَكثر، أَعني التي توجد لأَكثر الموضوع مثل وجود
الشيب للإِنسان في سن الاكتهال أَو التي توجد في أَكثر الزمان مثل اشتداد
الحر عند طلوع الشعري العبور، أَمكن نقضه من ثلاث جهات: إِحداها أَنها
ليست بمحمودة، والثانية أَن الذي على الأَكثر ليس باضطراري، وما ليس
باضطراري، فقد يمكن أَن يكذب. وهذا نقض مموه إِلا أَنه يستعمل في هذه
الصناعة؛ فإِنه قد يظن السامع، أَعني الحاكم، أَن المقدمة، إِذا كانت ليست
باضطرارية، أَنها ليست بمحمودة، فيعرض للسامع إِحدى حالتين: إِما أَن يظن
أَنه ليس كان ينبغي له أَن يحكم بشيء، وإِما إِن حكم، فلا بالسنة الخاصة
المكتوبة بل بالعامة. وهو ما يقتضي الأَصلح في تلك النازلة. فإِن الحاكم
إِنما يحكم بأَحد هذين الأَمرين: إِما بالسنة المكتوبة، وإِما بالعامة.
والوجه الثالث أَن نبين أَن الذي أَخذ على أَنه على الأَكثر ليس على
الأَكثر، بل هو إِما أَقلي وإِما مساوٍ، وذلك إِما في الموضوع، وإِما في
الزمان. مثال ذلك أَن شاكيا إِن قال عند الحاكم: هذا قتل زيدا، لأَنه وُجد
واقفا وبيده سيف، فيقول الخصم: إِن هذا وإِن كان أَكثريا فليس ضروريا.
وذلك أَنه ليس كل من وجد واقفا وبيده سيف هو قاتل. أَو يقول: إِنه ليس هو
أَكثريا، بل هو على التساوي، لأَن مَنْ هذه صفته يمكن أَن يكون قاتلا،
ويمكن أَن يكون ناصرا.
وأَما النوع من الضمائر التي تأتلف من العلامات في الشكل الثالث فهو يبطل
بوجهين: أَحدهما أَنه ليس بقياس، وذلك أَنه إِنما ينتج جزئيا لا كلية.
والثاني بإبطال النتيجة لإِبطال المقدمات. فإِن المقدمات في هذا الضرب من
الضمائر هي محسوسة. مثل قولنا: الكُتَّاب أَشرار؛ لأَن زيدا كاتب وزيد
شرير. فإِن بإِبطال النتيجة تبطل المقدمات. لكن ليس ينبغي أَن يستعمل في
إِبطال النتيجة المقابل المضاد ولا المهمل. فإِنها إِذا كانت كلية وأَبطلت
بالضد، كان ذلك إِبطالا للكاذب بالكاذب، وللشنيع بالشنيع، مثل أَن يبطل
قول القائل: كل كاتب شرير، بأَنه ولا كاتب واحد شرير. وإِن كانت مهملة
وأَبطلت بالمهمل، كان إِبطال الصادق بالصادق والمحمود بالمحمود. فإِنه
يصدق أَن الكُتَّاب أَشرار، والكُتَّاب ليسوا بأَشرار، كما يكذب أَن كل
كاتب شرير، وأَن كل كاتب ليس بشرير، بل إِنما ينبغي أَن يكون الإِبطال
بإِنتاج المقابل الذي هو موجود على الأَكثر. فإِنه إِذا كان المحمود
الثاني المنتج مقابلا للمحمود الأَول وهو أَكثري، كان المحمود الأَول
أَقليا. فإِذن إِنما ينبغي أَن يتحرى المبطل أَن يكون المقابل الذي ينتجه
للنتيجة التي يروم إِبطالها أَكثريا، أَعني أَنه يوجد لأَكثر الموضوع أَو
في أَكثر الزمان. وإِنما كان هذا مبطلا لأَنا إِذا تحققنا أَن المحمول
موجود لأَكثر الموضوع، ولم يكن ذلك بحسب الظن والاشتباه، فإِما أَن يكون
ضروريا، وإِما أَن يكون ذلك الأَقل من الموضوع الذي ليس هو فيه معلوما
محدودا.
وأَما العلامة التي في الشكل الثاني فإِنما تبطل من جهة أَنها ليست بقياس.
وأَما العلامة التي في الشكل الأَول فليس يمكن إِبطالها لا من جهة شكلها
ولا من جهة موادها، فلذلك هي ضمير مثبت ضرورة.
فأَما تكبير الشيء وتصغيره وإِن كان قد يلزم عنهما اطراح الشيء
واكتسابه، فإِنهما ليسا من أَنواع الضمائر المبطلة والمثبتة. وإِن كان
التعظيم والتخسيس إِنما يكونان عن ضمائر، لكن أَن يقبل الشيءَ ويصدق به من
نفس التعظيم أَو يطرح ويكذب به من نفس التخسيس ليس إِثباتا له ولا إِبطالا
بالذات ولا هو من أَنواع الضمائر. وأَيضا فليس كل ما يكون به الإِبطال
يكون ضميرا. وذلك أَن الإِبطال صنفان: إِما إِبطال لشكل القياس، وإِما
إِبطال للقضايا المنسوبة إِلى القياس. وهذا أَيضا صنفان: إِما إِبطال
للنتيجة نفسها بأَن ينتج مقابلها، وإِما إِبطال لمقدماتها المنتجة لها.
فأَما إِبطال القضايا سواء كانت نتائج أَو مقدمات، فإِنه يكون بالضمائر
وهي تأتلف من المواد الخاصة بهذه الصناعة. والمثبت هاهنا والمبطل يستعملان
جنسا واحدا من أَجناس القياس. وإِما إِبطال أَشكال المقاييس في هذه
الصناعة وغيرها فإِنما يكون بالمقاييس المنطقية، أَعني التي تؤلف من مواد
منطقية. فإِن في كل صناعة صنفين من القياس: قياس مؤلف من المواد الخاصة
بتلك الصناعة، وقياس مؤلف من مواد صنائع أُخر. وكلا الصنفين مستعمل في كل
صناعة. وإِبطال تأليف القياس في أَي صناعة كانت يكون ضرورة بقياس معمول من
مواد منطقية، إِذ كان تصحيح المقاييس وإِبطالها إِنما يكون بصناعة المنطق.
وهنا انقضى تلخيص هذه المقالة.
بسم الله الرحمن الرحيم
المقالة الثالثة
من كتاب الخطابة
قال: إِن الأَشياءَ التي ينبغي لصاحب صناعة المنطق أَن يتكلم فيها في هذه الصناعة، إِذا كان مزمعا أَن يكون كلامه فيها على المجرى الصناعي، ثلاثة أُمور: أَحدها الإِخبار عن جميع المعاني والأَشياء التي يقع بها الإِقناع.والثاني الإِخبار عن الأَلفاظ التي يعبر بها عن تلك المعاني وما يستعمل معها مما يجري مجراها.
والثالث كم أَجزاءُ القول الخطبي وكيف ينبغي أَن يكون ترتيبها ومماذا يأتلف كل جزء منها من الأَلفاظ والمعاني.
فأَما المعاني الفاعلة للتصديق فقد قيل فيها في المقالتين المتقدمتين وبين فيها على كم وجه تكون، ومن أَجل أَي شيء تكون. فإِنه قيل هنالك أَنها ثلاثة أَنواع: النوع الأَول: الأَقاويل الانفعالية والخلقية التي يقصد بها توطئة الحكام وإِعدادهم لقبول ما يراد منهم من التصديق بالشيء الذي فيه الإِقناع.
والنوع الثاني: الأَقوال التي يقصد بها إِثبات الفضيلة للمتكلم ليكون قوله أَقنع عند الحاكم والمناظر.
والنوع الثالث: الأَقاويل المستعملة أَولا في وقوع الإِقناع بالشيءِ المقصود إِيجاد الإِقناع فيه، وهي صنفا الأَقاويل القياسية المستعملة في هذه الصناعة أَعني الضمائر والمثل.
ولم يقتصر فيما سلف على تعريف أَصناف هذه الأَقاويل فقط، بل وعرف مع هذا الوضع التي منها تستنبط هذه الأَقاويل، وإِن هذه المواضع منها كلية تعم الضمائر المستعملة في الأَغراض الثلاثة من أَغراض الخطابة، ومنها جزئية تخص غرضا غرضا منها. وقيل هنالك إِن الأُمور الجزئيات التي من أَجلها تؤلف هذه الأَقاويل هي ثلاثة: إِما المشورية، وإِما المنافرية، وإِما المشاجرية.
والذي بقي هاهنا هو القول في الجزءين الباقيين. وذلك أَنه لما كان ليس بأَي معان اتفقت يقع الإِقناع، ولا بأَي أَحوال اتفقت أَن تستعمل تلك المعاني، بل بمعان مخصوصة، كانت الأَلفاظ أَيضا التي يعبر بها عن تلك المعاني شأنها هذا الشأن، أَعني أَن الإِجادة في العبارة عنها تكون بأَلفاظ مخصوصة مأخوذة بأَحوال مخصوصة في غرض غرض من أَغراض الأَقاويل الخطبية، وهو الذي يعبر عنه الجمهور باسم الفصاحة. فإِن هذا الاسم يطلق عندهم على أَحوال ثلاثة في الأَلفاظ: أَحدها وهو الأَملك بهذا المعنى أَن تكون الأَلفاظ جيدة الإِفهام والإِبانة للمعاني.
والثاني أَن تكون لذيذة المسموع.
والثالث أَن يعطى في المعنى رفعة أَو خسة.
فلهذا كان النظر في الأَلفاظ الخطبية ضروريا لصاحب المنطق، لكن
ليس ينظر منها في الأَحوال الخاصة بأُمة أُمة، بل إِنما ينظر من ذلك في
الأَحوال المشتركة بجميع الأُمم. ولهذا كان النظر فيها جزءاً من صناعة
المنطق. وأَما النظر من ذلك فيما يخص أُمة أُمة فمن شأن الخطيب المنصوب في
أُمة أُمة. وأَما ضرورة القول في الجزءِ الثالث، أَعني كم أَجزاء القول -
المسمى خطبة - العظمى والصغرى، وترتيبها، ومماذا تؤلف، وكيف تؤلف، فأَمر
بيَّن بنفسه.
وقبل أَن نقول في الأَلفاظ، فينبغي أَن نقول في الأُمور المستعملة مع
الأَلفاظ على جهة المعونة في جودة الإِفهام، وإِيقاع التصديق، وبلوغ الغرض
المقصود، وهي التي جرت عادة القدماء أَن يسموها: الأَخذ بالوجوه. وذلك أَن
هذه الأَشياء لما كان من شأنها أَن تميل السامعين إِلى الإِصغاءِ
والاستماع والإِقبال على المتكلم بالوجه وتفريغ النفس لما يورده، أَستعير
لها هذا الاسم. وهذه الأَشياءُ صنفان: إِما أَشكال، وإِما أَصوات ونغم.
والأَشكال، منها ما هي أَشكال البدن بأَسره، ومنها ما هي أَشكال لأَجزاء
البدن كاليدين والوجه والرأس. وهذه هي أَكثر استعمالا عند المخاطبة.
والأَشكال بالجملة يقصد بها أَحد أَمرين: إِما تفهيم المعنى وتخييله
الموقع للتصديق، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال في أَحد
خطبه: " بعثت أَنا والساعة كهاتين " وأَشار بإِصبعيه يقرنهما، وإِما تخييل
لانفعال ما أَو خلق ما. وذلك إِما في المتكلم، أَعني أَن يتخيل فيه أَنه
بذلك الانفعال أَو الخلق، مثل أَن يتكلم مصفر الوجه منفعلا بانفعال الخوف،
إِذا أَراد أَن يخبر أَنه خائف، أَ، بتوءَدة توهم أَنه عاقل. وإِما في
المخبر عنه، إِذا أَراد أَن يصوره بصورة الخائف أَو العاقل. وإِما أَن
يوقع ذلك الانفعال في نفس السامع أَو ذلك الخلق حتى يستعد بذلك إِما نحو
التصديق الواقع عن ذلك الانفعال أَو الخلق، وإِما نحو الفعل الصادر عنه.
وأَما النغم فإِنها تستعمل في القول الخطبي لوجوه: منها لتخييل الانفعالات
أَو الخلق، وذلك أَيضا لثلاثة وجوه: أَحدها عندما يريد المتكلم أَن يخيل
أًَنه بذلك الانفعال أَو الخلق عند السامعين، مثل أَنه إِذا أَراد أَن
يخيل فيه الرحمة رقق صوته، وإِذا أَراد أَم يخيل فيه الغضب عظم صوته وكذلك
في الأَخلاق. وإِنما كان ذلك كذلك، لأَن هذه الأَصوات توجد بالطبع صادرة
عن الذين ينفعلون أَمثال هذه الانفعالات. والوجه الثاني: أَن يكون قصده
تحريك السامعين نحو انفعال ما أَو خلق ما، إِما لأَن يصدر عنهم التصديق
الحاصل عن ذلك الانفعال أَو الخلق أَو الفعل الصادر عنه.
والوجه الثالث عندما يقتص عن مخبرين عنهم بأَن يصفهم بذلك الانفعال أَو
الخلق.
ومنها أَيضا أَنها تستعمل لضرب من الوزن في الكلام الخطبي على ما سيقال
بعد. وهذا الضرب من النغم ضروري في أَوزان أَشعار من سلف من الأُمم ما عدا
العرب. فإِن من سلف من الأُمم كانوا يزنون أَبياتهم بالنغم والوقفات،
والعرب إِنما يزنونها بالوقفات فقط.
ومنها أَنها تستعمل أَشعارا في افتتاح القول وختمه ومواضع الوقف.
وينبغي أَن تعلم أَن الأَخذ بالوجوه ليس له غناء في الخطب
المكتوبة، وإِنما غناؤه في المتلوة، وإِن عادة العرب في استعماله قليلة،
وأَما من سلف من الأُمم فربما أَقاموها في الأَشعار مقام الأَلفاظ، أَعني
التشكيلات، ويحذفون اللفظ الدال على ذلك المعنى، إِما إِرادة للاختصار
وإِما طلبا للوزن، والإِلذاذ. وهذا لم تجر به عادة العرب. لهذا صار ما
يقوله أَرسطو في كثير من هذه الأَشياءِ، كما يقول أَبو نصر، غير مفهوم
عندما ولا نافع. والأَخذ بالوجوه إِنما هو نافع أَكثر ذلك في الخطب التي
تتلى على جهة المنازعة، لأَنه إِنما يحتاج إِلى الاستعانة بجميع الأَشياء
المقنعة في موضع المنازعة لتحصل الغلبة. وأَمثال هذه الخطب هي الخطب التي
كانت بين علي ومعوية. وأَمثال ذلك في الأَشعار: الأَشعار التي كانت بين
جرير والفرزدق. وإِنما صارت هذه الأَفعال معينة في الإِقناع، لأَن فيها
ضربا من تغيير الأَلفاظ وإِبدالها، على ما سيقال في سبب ذلك فيما بعد.
وهذا الفعل هو ضرب من التمويه والمغالطة، إِلا أَنه نافع في هاتين
الصناعتين، أَعني الشعرية والخطبية، إِذ كانت الخطبية إِنما يقصد بها وقوع
غلبة الظن، والشعرية حصول التخييل نفسه، ولذلك تستعمل من الأَشكال والنغم
في طل المحاكاة ما إِن استعمل في الخطابة، كان خروجا عن الواجب.
وإِذ قد قلنا في توابع الأَلفاظ، فلنقل في الأَلفاظ.
القول في الأَلفاظ المفردة
فنقول: إِن القول في أَحوال الأَلفاظ التي تكون بها أَتم إِبانة عن
المعاني وأَجود تفهيما لها هو ضروري في المخاطبة البرهانية، فضلال عن
الأَقاويل البلاغية والشعرية. ولذلك أَن جهة استعمالها في المخاطبة
البرهانية إِنما هو لأَن يكون بذلك حصول البرهان أَيسر وأَسهل وأَوضح، مثل
ما يقال: إِنه ينبغي أَن تكون الأَلفاظ المستعملة فيه متواطئة، غير
مشتركة، مشهورة عند الجمهور أَو عند أَهل تلك الصناعة التي يستعمل فيها
ذلك البرهان. وإِن كانت مشتركة، أَن تقسم جميع المعاني التي يقال عليها
ذلك الاسم المشترك، ويبرهن على كل معنى من تلك المعاني على حدته، لأَن
للأَلفاظ في ذلك معونة في زيادة التصديق الحاصل عن البرهان وقوته كالحال
في الصنائع الأُخر، فإِنه يلفى لها معونة في إِيقاع التصديق المستعمل
فيها. وإِن كانت في ذلك تختلف، فأَقلها حاجة في ذلك صناعة الجدل، ثم من
بعدها السفسطة، ثم من بعدها صناعة الشعر. فهاتان الصناعتان أَكثر حاجة
إِلى ذلك. فلذلك ما ينبغي في هاتين الصناعتين أَن تحصى الأَحوال التي إِذا
استعملت في الأَلفاظ كانت بها الأَقاويل البلاغية أَتم إِقناعا، والشعرية
أَتم تخييلا. فإِنه كما أَن الأَخذ بالوجوه. إِنما منفعته في هاتين
الصناعتين هذه المنفعة، كذلك الحال في الأَلفاظ. إِلا أَن القول في أَحوال
الأَلفاظ التي بها تكون الأَقاويل في هاتين الصناعتين أَتمَّ فعلا أَعظمُ
نفعا وأَحرى أَن يكون القول في ذلك صناعيا. فإِن الأَخذ بالوجود أَكثر ذلك
طبيعي. وإِنما صارت الأَلفاظ والأَصوات تفعل في هاتين الصناعتين هذا الفعل
من جهة أَنها تخيل في المعنى رفعة أَو خسة، وبالجملة: أَمراً زائداً على
مفهوم اللفظ، مثل غرابة اللفظ فإِنها تخيل غرابة المعنى، وكذلك فخامته
تخيل فخامة المعنى، والنغم كذلك يفيد فيه هذا المعنى أَيضا. وبيَن أَن هذا
مقصود بالطبع للمتكلم على طريق هاتين الصناعتين. وليس يقصد ذلك أَحد عندما
يتكلم على طريق الهندسة، ولا على طريق العدد. والذين وقعوا أَولا على
تأثير هذه الأَحوال من الأَلفاظ والأَصوات في الأَقاويل هم الشعراءُ. وذلك
أَن هذا المعنى أَظهر ما يكون في الأَقاويل الشعرية، مع أَن الوقوف على
الأَقاويل الشعرية هو متقدم بالزمان على الوقوف على الأَقاويل البلاغية.
وإِذا قد تقرر هذا من ضرورة القول في الأَلفاظ في هاتين الصناعتين، فينبغي
أَن نذكر من ذلك ما يخص البلاغة وما هو مشترك بين تلك الصناعتين معا،
فنقول: إِن الأَلفاظ المفردة، كانت اسما أَو كلمة أَو حرفا، تنقسم من جهة
أَنحاءِ دلالاتها ثمانية أَقسام: منها المستولية؛ ومنها المغيرة، ومنها
الغريبة، ومنها اللغات، ومنها المزينة، ومنها المركبة، ومنها المغلطة،
ومنها الموضوعة.
أَما المغيرة: فهي أَشهرها وأَكثرها نفعا في الصناعتين. وأَما
التغيير أَن يكون المقصود يدل عليه لفظٌ ما فيستعمل بدل ذلك اللفظ لفظٌ
آخر. وهذا التغيير يكون على ضربين: أَحدهما: أَن يستعمل لفظ شبيه الشيء مع
لفظ الشيء نفسه ويضاف إِليه الحرف الدال في ذلك اللسان على التشبيه؛ وهذا
الضرب من التغيير يسمى التمثيل والتشبيه، وهو خاص جدا بالشعر.
والنوع الثاني من التغيير: أَن يؤتى بدل ذلك اللفظ بلفظ التشبيه به أَو
بلفظ المتصل به من غير أَن يؤتى معه بلفظ الشيء نفسه. وهذا النوع يسمى في
هذه الصناعة الإِبدال، وهو الذي يسميه أَهل زماننا بالاستعارة والبديع،
مثل قول ابن المعتز:
يا دار أَين ظباؤك اللُّعْس ... قد كان لي في إِنسها أُنس
فإِن العرب جرت عادتهم أَن يشبهوا النساء بالظباءِ، فربما أَتوا به على
جهة الإِبدال، مثل ما تقدم من قول ابن المعتز، وربما أَتوا بذلك مع حرف
التشبيه. وكل واحد من صنفي التغيير: إِما بسيط وإِما مركب. وكل واحد من
هذين: إِما أَن يكون وجه الاتصال فيه بينا مشهورا من أَول الأَمر، وإِما
أَن يكون غير بين. وإِنما يكون غير بين لأَحد شيئين: إِما لأَنه غير بين
في نفسه عند الجميع، أَو عند كثير من الأُمم، مثل كثير من التمثيلات التي
جرت عادة العرب أَن يستعملوها، فإِنه يشبه أَن يكون كثير منها غير بين عند
سائر الأُمم، مثل قول امرئ القيس يصف حمار الوحش:
يهيل ويُذرى تُربها ويُثيره ... إِثارة نبَّات الهواجر مُخمسِ
فإِن نبات الهواجر إِنما تعرفه العرب ومَنْ هو مثلهم ممن يسكن البراري
والصحاري.
وأَما المركبة فهي خاصة بالشعر، كما أَن البسيطة خاصة بالخطابة. وأَنشد
أَبو نصر في مثال المركبة البعيدة التركيب، الخفية الاتصال، بيتا نسبه
لامرئ القيس:
بدلتُ من وائل وكندة عد ... وان وفهماً صَمّى ابنةَ الجبل.
قال: فإِن هذا التعبير فيه تركيب كثير. وذلك أَنه جعل " ابنة الجبل " بدلا
من قوله " الحصاة " ، وجعل قوله " صمى " بدلا من عدم صوت الحصاة. فإِن عدم
الصوت وعدم السمع يتقاربان، فإِنه قسيمه، إِذ كان عدم السمع إِما أَن يكون
عن عدم الصوت، وإِما لفساد في الحاسة. وجعل عدم صوت الحصاة بدلا من ابتلال
الأَرض، فإِن الأَرض إِذا ابتلت وطرحت فيها الحصاة لم تصوت. وجعل ابتلال
الأَرض بدلا من انصباب الدماء على الأَرض، فإِن ابتلال الأَرض لاحق من
لواحق انصباب الدماء. وجعل انصباب الدماء عليها بدلا من القتال الشديد،
لأَن انصباب الدماء يكون عن القتال الشديد. وجعل القتال الشديد بدلا من
الأَمر العظيم. فكأَنه أَراد: وفيها أَمر عظيم، فأَبدل مكان ذلك: وفهما
صمّى ابنة الجبل، واستعمل في ذلك هذا الإِبدال الكثير. وهذا كما قلنا
إِنما يليق بالشعر.
والمستولية هي الأَلفاظ التي هي خاصة بأَهل لسان ما، ومشهورة عندهم،
مبتذلة، دالة على المعاني التي وضعت لها من أَول الأَمر من غير توسط.
وأَما الغريبة فهي الأَلفاظ التي هي غير مبتذلة عند جمهورهم، وغير مستعملة
عندهم بل إِنما يستعملها الخواص منهم.
وأَما اللغات فهي صنفان: أَحدهما أَن يستعمل الإِنسان مخاطبة صنف صنف من
أَصناف أْمة لفظا ليس يستعمله ذلك الصنف من الأُمة، بل إِنما يستعمله صنف
آخر منه، مثل أَن يستعمل الحجازي لغة حميرية. والصنف الثاني أَن يستعمل في
مخاطبة أُمة ما لفظا ليس من أَلفاظ أَهل لسانهم، وإِنما هو من لسان أُمة
أُخرى، مثل ما يوجد في لسان العرب أَلفاظ كثيرة من أَلفاظ الفرس والأُمم
المجاورة لهم. وهذا يستعمل على وجهين: أَحدهما أَن يأتي بذلك اللفظ بعينه
من غير أَن نغير بنيته وتركيبه. والوجه الثاني أَن يغيره تغييرا يقرب به
من الأَبنية المستعملة في لسانهم ليسهل بذلك عليهم النطق به، مثل السّجيل
وغير ذلك مما هو موجود في كتب اللغة.
وأَما المزينة والمركبة فليستا موجودتين في لسان العرب؛ وذلك أَن المزينة
هي أَلفاظ جعل بعض أَجزائها نغما حتى صارت بتلك النغم مزينة. وهذا غير
موجود في لسان العرب.
وأَما المركبة فإِنها أَيضا غير موجودة في لسان العرب إِلا قليلا شاذا مثل
قولهم عبقسي في المنسوب إِلى عبد القيس، وعبشمي، في المنسوب إِلى عبد شمس.
وأَما المغلطة فهي الأَلفاظ التي يعسر النطق بها. وذلك يعرض
لأَسباب: منها أَن تكون تلك الحروف حروفا يعسر النطق بها، وإِن كانت
قليلة. ومنها أَن يكون سبب العسر فيها كثرة الحروف التي ركبت منها والتي
يعسر النطق بها: إِما أَن يكون من أَجل مخرج الحرف نفسه، وإِن نطق به
وحده، مثل كثير من حروف الحلق؛ وإِما أَن يكون العسر يحدث له عند تركيبه
مع غيره، وذلك إِما لتقارب مخارجها، وهذا هو سبب الادغام في لسان العرب،
وإِما لتكرارها مثل قولهم قصصت أَظفاري. ولذلك بعض العرب يبدل إِحدى
الصادين ياء في مثل هذا. وربما كان السبب في ذلك تضاد المخارج، ولذلك قل
في لسان العرب اسم يوجد على وزن فُعُل مثل الرسل. وأَكثر الانقلابات
والتغييرات التي يصفها النحاة هذا هو سببها. وأَما الموضوعة فهي الأَلفاظ
المخترعة في لسان جنس ما، يخترعها بعضُ أَهل ذلك اللسان على نحو التركيب
الذي لحروفهم.
فهذه أَصناف الأَسماء النافعة في هاتين الصناعتين، وهي كالمادة للصناعتين،
أَعني الشعرية والخطبية، وإِن كانت بالشعرية أَخص، ولذلك أَحصاها أَرسطو
في كتاب الشعر.
وإِذ قد تقرر هذا، فالذي ينبغي أَن يبين هاهنا من أَمرها هو أَي صنف من
هذه الأَصناف تستعمل هذه الصناعة وأَيها لا تستعمل. وإِذا استعملت منها
صنفا، فكيف تستعمله، وإِلى أَي مقدار تنتهي في استعماله، وفي أَي موضع
تستعمل منه ما تستعمل. وبالجملة: فنتحرى تلخيص ما يقوله أَرسطو في ذلك
بأَوجز ما يمكننا وأَتمه، فنقول: إِنه يقول: إِن فضيلة القول الخطبي أَو
الشعري وجودته إِنما تكون بالتغيير. وأَعني هاهنا بالتغيير استعمال أَصناف
الأَسماء والكلم السبعة ما عدى المستولية. فإِن في كل واحد منها، ما عدى
هذا الصنف، تغييرا ما. وإِنما كان القول الذي في هاتين الصناعتين فضيلته
في التغيير، لأَن القول إِنما هو علامةُ معرفة لأَمرٍ ما لم يعرف أَصلا،
أَو لم يعرف معرفة تامة. وإِنما يكون القول بهذه الصفة متى أَفاد في
المعنى المدلول عليه أَمراً لم يكن بعدُ عند السامع، أَو إِن كان، لم يكن
على التمام. وهذه هي حال القول الذي من الأَلفاظ المغيرة. فإِن القول
المؤلف من الأَلفاظ المستولية ليس يفيد معنى زائدا على ما كان عند السامع،
وإِنما يفيد ذلك إِذا كان مغييرا بالتخييل الذي تعطيه الأَلفاظ المغيرة.
وهذا المعنى إِنما يوجد في القول بشرطين: أَحدهما أَلا تكون الأَلفاظ
حقيرة وهي بالجملة الأَلفاظ المبتذَلة التي لا تخيل في المعنى أَمراً
زائداً على ما كان عند السامع، أَو التي يكون تخييلها يسيرا، أَو التي
تخيل في الشيءِ خسةً ما، أَو يكون تركيبها تركيبا فاسدا.
والشرط الثاني أَلا تكون مجاوزة للقدر الذي يجب بحسب المعنى الذي يطلب
الإِقناع فيه. وذلك يكون إِما بأَن لا تخيل فيه معنى أَعظم مما يحتمل
المعنى المقصود تبيينه، أَو يكون التغيير فيها غير بين الاتصال.
فإِذا جمع القول الخطبي أَو الشعري مع التغيير هاتين الشريطتين كان تام
الفعل، وذلك هو فضيلته، وهو القول الجميل. ويشهد لوجود هذا الفعل للقول
المغير الأَقاويل الشعرية، فإِنها إِنما صارت لذيذة لما فيها من التخييل
والوزن، وكلاهما تغيير. وأَما الأَلفاظ المستولية فإِنها تجعل القول
محققا، وليس تخيل فيه معنى زائداً. ولذلك هي أَليق بالبرهان منها بغيرها
من الصنائع، إِلا أَنها متى استعملت في هذه الصنائع، فينبغي أَن يكون
تركيبها تركيبا مطابقا لتركيب المعاني في النفس، أَعني التركيب الذي يكون
لها على المجرى الطبيعي. وبالجملة فينبغي أَن يكون فيها من شروط التركيب
الشروط التي تقال فيما بعد. وإِذا كانت بهذه الصفة كانت، كما يقول أَرسطو،
بهيئة نبيلة غير حقيرة.
فهذا بالجملة هو الفرق بين فعل الأَسماء المستولية والمغيرة في القول
الخطبي والشعري.
وإِنما كانت الأَلفاظ المغيرة تعطي في المعنى أَمراً زائدا لموضع
الغرابة فيها. فإِنه كما يعرض لأَهل المدينة أَن يتعجبوا من الغرباء
الواردين عليهم، وتخشع لهم أَنفسهم، كذلك الأَمر في الأَلفاظ الغريبة عند
ورودها على الأَسماع. فينبغي لمن أَراد أَن يجيد القول في هاتين الصناعتين
أَن يجعله غريبا. والأَلفاظ الغريبة تتفاضل بالأَقل والأَكثر فيما تخيل في
المعنى الواحد بعينه من الرفعة والخسة، لتفاضلها في الغرابة. والصناعة
الشعرية فتستعمل من ذلك ما هو أَكثر تخييلا. وأَما صناعة الخطابة، فإِنها
تستعمل من ذلك ما هو أَقل وبمقدار ما يليق بها، وذلك هو القدر الذي يفيد
وقوع الإِقناع في الشيءِ المتكلم فيه. فإِن ذلك أَيضا يتافضل في صناعة
الخطابة بحسب اختلاف ما فيه القول. مثال ذلك ما يحكى أَن المنصور لما دخل
الكعبة رأَى رجلا قد سبقه بالدخول، وقد كان أَمر أَلا يدخل إِليها أَحد
قبله من العامة، فقال له: أَما سمعت النداءَ؟ فقال: بلى ! فقال: أَو ما
تعرفني؟ فقال بلى. فقال له: فكيف تجاسرت؟ فقال له الرجل: وكيف لا أَتجاسر
عليك؟ ! وهل أَنت في أَول أَمرك إِلا نطفة مذرة؟ وفي آخر أَمرك إِلا جيفة
قذرة، وأَنت فيما بين هذين تحمل العذرة؟! فخلى عنه، إِذ صغرت بهذا القول
عنده نفسه، أَعني نفس المنصور. زقد كان له أَن يستعمل معه تغييرات هي أَقل
في التحقير من هذه، مثل أَن يقول له: وهل أَنت إِلا ملك من الملوك، أَو هل
أَنت إِلا رجل من الناس، أَو هل أَنت إِلا عبد من عبيد الله. فإِن هذه
كلها متفاضلة في التصغير. إِلا أَنه يشبه أَنه ما كان ينجو من سطوته إِلا
بمثل هذا التصغير الذي استعمل معه. فإِنه قول مخسس جدا.
قال أَرسطو: والخطباءُ ربما استعملوا أَثناءَ خطبهم التغييرات الشعرية،
أَعني البعيدة، فيتوهم من ليس له بصر بالفرق بين التغيير الشعري والخطبي
أَن ذلك الفعل الصادر عن ذلك التغيير هو من فعل الأَقاويل الخطبية، وليس
الأَمر كذلك. وإِنما مثال ذلك مثل من يخلط سَقَمونيا بشراب الورد. فإِذا
أَسهل ذلك الشراب، أَوهم أَن ذلك الإِسهال إِنما كان عن فعل شراب الورد
عند من لا معرفة له بقوة الورد. وكذلك الشاعر أَيضا ربما أَلَّف من
الأَلفاظ المستولية المعهودة قولا موزونا فأَوهم أَنه شعري وليس بشعري
وإِذ قد تبين أَن الفضيلة في القول الخطبي أَن يستعمل التغيير، وتبين
بالجملة أَي مقدار ينبغي أَن يستعمل منه فينبغي أَن نقول في مقدار ما
تستعمله في واحد واحد من أَصناف الأَلفاظ المفردة السبعة، أَعني ما عدى
المستولية. فإِن التغيير يقال عليها بعموم وخصوص. فنقول: أَما اللغات
والمركبات فينبغي أَن يقلل من استعمالها الخطيبُ. وإِذا استعملها، فلا
يستعمل منها ما يخيل في الشيءِ معنى مفرطا، مثل الأَسماء الغريبة عن لسان
أُمة ما أَو الأَسماء المركبة الدالة على معان تخيل في الشيءِ المدلول بها
عليه أَمراً زائدا ومفرطا عما تقتضيه صناعة الخطابة، وبخاصة في الخطب التي
يقصد بها إِقناع الجميع. فإِن أَمثال هذه الخطب إِنما ينبغي أَن تؤلف من
المستولية والغير المشتركة الأَلفاظ وهي التي تعرف بالأَهلية.
ومن المغيرات الغريبة: التغييرُ بخلاف الأَمر في الشعر وبخلاف الأَمر
أَيضا في الخطب التي يقصد بها إِقناع خواص من الناس. فإِن هذه، الغرابةُ
ينبغي أَن تكون فيها أَكثر. والاسم المشترك أَخص بها من الأَهلي؛ وبخاصة
القول الشعري، فإِنه ينبغي أَن يجمع الغرابة من جميع الجهات، وفي الغاية.
مثل أَن يكون بأَلفاظ مغيرة في الغاية، وأَلفاظ غريبة في الغاية، ومشتركة.
والمشتركة أَخص بالسفسطة من غيرها من الصنائع. والخطيب يستعملها بقدر ما
يستعمل من المغالطة في هذه الصناعة، على ما سلف. وأَما الأَسماءُ
المترادفة فصالحة جدا لصناعة الشعر، وقد تصلح أَيضا لصناعة الخطابة.
والشاعر يستعمل هذا الصنف لأَسباب أَخصها به استعمالها لتصحيح الوزن
وللقافية، مثل قوله:
ومنذ أَتى من دونها النأي والبعدُ
والخطيب يستعملها للاستظهار، وربما استعملها على جهة المغالطة
وإِيهام تكثير المعنى بتكثيرها عند التقسيم. وإِذا استعملها الشاعر،
فينبغي أَن يستعمل منها ما يخيل في المعنى أَمراً زائدا على ما يخيله
الاسم الآخر، مثل قولنا: الصهباء، وخندريس، وقَرْقَف، وحميا. فإِن هذه
الأَسماء كلها، وإِن كانت مترادفة، فإِنها تخيل في الخمر معاني مختلفة.
وربما استعمل الخطيب المترادفة عند إِرادته تكرير المعنى الواحد بعينه
لحفظه وتأكيده، فإِنه أَحسن من أَن يكرر ذلك المعنى بلفظ واحد. وأَما
أَيما هي التغييرات الحسنة المناسبة الجميلة في هذه الصناعة التي ينبغي
أَن يستعملها وأَيما هي التغييرات الباردة التي لا ينبغي أَن يستعملها،
فينبغي أَن نقدم، لمعرفة ما يجب من ذلك، معرفة أَصناف التغيير وضروبه،
وإِن كان ذلك أَخص بكتاب الشعر. فإِن التغيير ينبغي أَن يكون نفعه في
الصناعتين على نسبة نفع الوزن فيهما، ولذلك كان أَخص بالشعر لكون الوزن
أَخص به. وإِنما تَستعمل هذه الصناعة من التغيير بقدر ما تستعمل من الوزن،
وذلك شيء يسير.
والتغيير بالجملة يعطي في المعنى جودة إِفهام وغرابة، ولذة. والتغييرات
صنفان: إِبدال وتمثيل. والتمثيل صنفان: إِما مضاف، وإِما من سائر
المقولات، على ما قيل في غير ما موضع. والإِبدال: إِما إِبدال من الشبيه،
وإِما إِبدال من اللازم. واللازم ثلاثة: إِما متقدم على الشيءِ، وإِما
مقارن له، وإِما متأَخر عنه. والمتقدم صنفان: إِما سبب الشيء وإِما كلي
الشيءِ. والمقارن: إِما زمان الشيءِ، وإِما مكانه، وإِما أَنواعه القسيمة،
وإِما مقابلاته الأَربعة، أَعني الأَضداد والموجبة والسالبة والعدم
والملكة والمضافين والأَشياء الموجودة مع الشيءِ بالعرض. والمتأَخر هي
لواحق الشيءِ، وجزئي الشيءِ. وكل واحد من هذه: إِما بسيط، وإِما مركب.
والمركب هو أَن يبدل الأَمر بشيء ما، ويبدل مكان ذلك الشيء شبيهه ويؤخذ
بعد ذلك لازم ذلك الشبيه مكان ذلك الشبيه، ثم يؤخذ عرض ذلك اللازم بدل ذلك
اللازم، فيغمض الوقوف على مثل هذا النوع من التغييرات، مثل ما عرض في بيت
امرئ القيس في قوله: صمَّى ابنة الجبل، إِذ استعمل ذلك بدلا من الأَمر
العظيم. وقد قلنا كيف وجه التركيب في هذا الإِبدال فيما سلف.
وإِذ تقرر هذا فلنشرع في الوصايا التي يرى أَرسطو أَنه ينبغي للخطيب أَن
يستعملها في التغيير والإِبدال فنقول: إِن أَرسطو يقول: إِنه ينبغي للخطيب
أَن يستعمل من التغييرات والإِبدالات ما كان مناسبا مشاكلا لما فيه القول.
ويعني بالمشاكل أَن الأَمر الواحد بعينه يمكن فيه أَن يغير تغييرات
متضادة، فالمناسب منها هو الذي يلائم الأَمر الذي فيه الإِقناع. مثال ذلك
أَن الذي يريد أَن يعظم أَمر الذي سرق، فالمشاكل هو أَن يقول: إِنه حارب.
والذي يريد أَن يحقر ذلك يقول: إِنه أَخذ. ثم لا يخلو الخطيب، إِذا أَتى
بالمشاكل المناسب، أَن تكون مشاكلته لما فيه القول ظاهرة بنفسها مشهورة،
أَو تكون غير ظاهرة. فإِن كانت ظاهرة، اكتفى بالإِتيان بالمناسب وحده.
وإِن لم تكن المشاكلة بينة، قرن بها الضد، وذلك أَن يأتى بضد ذلك المناسب
وضد الشيء الذي أَخذ المناسب بدلا منه. فإِن مشاكلات الأَضداد أَضداد.
ومثال ذلك في المحسوسات أَن الذي يشاكل الشيخ من اللباس غير الذي يشاكل
الشاب. وكذلك ينبغي أَن يكون الأَمر في الأَلفاظ. فهاتان وصيتان اثنتان:
إِحداهما أَن يستعمل المشاكل البين، والأُخرى أَن يستعمل الغير البين،
بأَن يقرن به ضده، فإِنه يفيده وضوحا وظهورا.
والتغييرات المناسبة ينبغي أَن تكون إِلى ما في الجنس، لا إِلى
أَشياء خارجة عن الجنس الذي فيه القول. فإِذا أَراد الخطيب أَن يحسّن،
فيجعل التغيير إِلى الذي هو أَفضل في ذلك الجنس. وإِذا أَراد أَن يقبح،
جعل التغيير إِلى الأَخس في ذلك الجنس. مثال ذلك أَن الشفاعة والتضرع
داخلان تحت جنس واحد، وهو المسئلة. والتضرع أَخس من الشفاعة. وذلك أَن
التضرع يكون ممن هو دون، والشفاعة من المساوي. فمتى أَردنا أَن نحسن
التضرع سميناه شفاعة، ومتى أَردنا أَن نخسس الشفاعة سميناها تضرعا. وكذلك
إِذا أَردنا أَن نعظم الشيءَ الواحد بعينه سميناه بالأَعظم من ذلك الجنس.
وإِذا أَردنا أَن نصغره سميناه بالأَصغر. مثال ذلك أَن من سرق، إِذا
أَردنا أَن نعظم أَمره، قلنا: إِنه حارب؛ وإِذا أَردنا تصغيره، قلنا: إِنه
خان. وذلك أَن هذه الأَفعال كلها داخلة تحت أَخذ المال دون عوض ولا رضى من
ذي المال.
وإِذا أُريد أَن يكون التغيير مفهما للشيءِ، فينبغي أَن يؤتى به من
الأَشياءِ التي هي واحدة بالنوع. وذلك في الأَشياءِ التي لا أَسماء لها،
لأَن التي لها أَسماء، في أَسمائها كفاية في تفهيمها. والتغيير الذي بهذه
الصفة يجعل القول محققا، فيقل تخييله. فربما كان الأَنفع في مواضع أَن
يكون التغيير فيه رمزاً ما وأَشكالا.
وحسن الاسم يكون بأَن يؤتى فيه بلفظ غير مستبشع ولا ثقيل. وذلك يكون بأَلا
يصرح باسم الشيءَ الخاص به. وهذا هو الذي يسمى كناية. فإِن التصريح
بأَسماءِ الأَشياءِ في أَكثر الأَمر مستبشع. وذلك يكون بأَوجه، أَحدها:
أَن يؤتى بلفظ إِما أَعم من الشيءِ، وإِما أَخص منه. والثاني: إِذا كان
المعنى المغير عنه قبيحا فتجعل العبارة عنه بلفظ مشترك بين ذلك المعنى
القبيح ومعنى آخر مما ليس بقبيح، وهو الذي يسميه أَرسطو الكلام المفوض.
والثالث: أَن تجعل العبارة عنه بالعلامة الخاصة به المنعكسة عليه في
الحمل. وهذا التغيير يجعل الأَمر بينا حتى كأَنه بحذاءِ العين. ويقل
استعمال مثل هذا التغيير، وذلك بعكس ما عليه الأَمر في الوجه الأَول. وذلك
أَنه ليس يكاد أَن يوجد شيء له اسم خاص إِلا وقد يمكن أَن يعبر عنه بلفظ
عام. وأَما العلامات فيقل وجودها، ولكن إِذا وجدت فاستعمالها مشهور، وهي
قريبة الدلالة على الشيءِ. والوجه الرابع أَن يكنى عن الشيءِ بالضد أَو
بالأَكثر والأَقل. أَما الضد، فمثل قوله تعالى: " كانا يأكلان الطعام " .
وأَما استعمال الأَكثر والأَقل فمثل أَن ينبه بالأَكثر على الأَقل أَو
بالأَقل على الأَكثر. مثال ذلك أَن يمدح الإِنسان بحضرة من هو أَزيد فضيلة
منه، ينبه بذلك على نقصان فضيلته؛ أَو يذم الأَنقص فضيلة منه، لينبه بذلك
على نقصان فضيلته. وربما كان مدح إِنسانٍ ما تعريضاً بالمذمة لإِنسان آخر.
وبالعكس. وذلك إِذا كان بيناً من أَمر ذينك الإِنسانين أَنهما متباينان في
الخلق والسيرة والنسب وسائر الأَشياء التي تعد فضيلة. ولذلك قال ذلك في
التعريض: ما أُمي بزانية ولا أَبي بزان. وقد يكون التعريض بالتشبيه في مثل
هذا الموضع، إِلا أَنه إِذا كان التصريح بالشيءِ قبيحا، كان التشبيه
البعيد في ذلك أَحسن من القريب. فإِن الشيءَ الواحد بعينه قد يغير تغييرات
مختلفة، فيتفاوت ذلك الشيءُ في الحسن والقبح، بحسب تفاوت الأَشياء التي
وقع التغيير إِليها، أَعني الأَشباه. مثال ذلك أَن يصف واصف امرأَة مخضوبة
اليد بالحناءِ، فيقول فيها: حمراء الأَطراف، أَو قرمزية الأَطراف، أَو
وردية الأَطراف، أَو كما قال:
من كف جارية كأَن بنانها ... من فضة قد طوقت عنابا
فإِن قولنا: وردية الأَطراف إِبدال حسن، وكذلك قولنا: عنابية
الأَطراف. وقولنا: حمراء الأَطراف أَخس منه. وأَقبح من هذا قولنا: قرمزية
الأَصابع. ولو قال فيها: " دَمّية الأَصابع " لكان أَن يكون هجوا أَقرب
منه إِلى أَن يكون مدحا. ولذلك يتفاوت التخييل لتفاوت الأَمور التي وقع
الإِبدال بها في الحسن والشرف. والأَشياءُ تكون شبيهة بأَحد ثلاثة
أَشياءِ: إِما باشتباه المنظر في الخلق واللون، وإِما أَن تكون أَنواعها
أَو أَجناسها واحدة، وإِما أَن تكون أَفعالها واحد. ولما كانت الأَقاويل
الخطبية والشعرية قد تكون حكاية عن أُمور موجودة وعن أُمور غير موجودة، بل
مخترعة يخترعها الشاعر أَو الخطيب، مثل الذي في كتاب دمنة وكليلة، وإِن
كان الاختراع أَخص بالشعر منه بالخطابة، ولذلك فصلت أَنحاء الاختراع في
كتاب الشعر، فينبغي أَن تعلم أَيضا أَن التغيير في الصنف المخترع يلحقه
أَيضا من الحسن والقبح ما يلحق التغيير الذي يكون في الأُمور الموجودة.
وقد يلحق ذلك أَيضا في الشيءِ الواحد بعينه، مثل ما حكى أَرسطو عن بعض
القدماءِ أَنه قال في حكاية حكاها عن البغال إِنها كانت مسرورة بانضمامها
إِلى بنات الخيل، على أَنها قد كانت أَيضا بنات الحمير. قال: فإِن قوله في
البغال: بنات الخيل، تشريف لها، وقوله فيها: بنات الحمير تخسيس لها.
ومن التغييرات تغيير يعطى في الشيءِ الإِفراط في التصغير والتعظيم، وهي
خاصة بالشعر. وينبغي أَن يستعمل من التعظيم ومن التصغير في الخطابة بقصد،
مثل من يقول في ذهب ذهيب، وفي ثوب ثويب، وفي إِنسان، أُنيسيان.
والوقف في غير مكان الوقف أَو وضع العلامات التي تدل على الوقف في غير
مكانها هو أَيضا ضرب من التغيير الرديء.
والأَسماءُ الباردة التي ينبغي للخطيب أَن يتجنبها أَربعة أَصناف، وهي
بالجملة الأَسماءُ التي يعسر تفهم المعنى منها، أَو التي تخيل في المعنى
أَحوالا زائدة على التي يحتاج إِليها.
فأَحد أَصناف الأَسماء الباردة هو أَن يستعمل من ضروب الأَسماء المركبة ما
يخيل في الأَمر معنى غير مشهور ويعسر الوقوف عليه، أَو يخيل فيه عرضا
بعيدا. وأَمثال هذه الأَسماء ليست توجد في لسان العرب.
والصنف الثاني استعمال اللغات وذلك على وجهين: أَحدهما أَن يستعمل منها في
مخاطبة أُمة ما هو من غير لسانها، بل من لسان أُمة أُخرى غريبة منها.
والثاني أَن يستعمل في مخاطبة تلك الأُمة الأَسماء الغريبة المفرطة
الغرابة الموجودة في لسانها.
والصنف الثالث أَن يستعمل من الأَسماءِ الموضوعة، وهي المنقولة،
ما لا يخيل منها المعنى الذي نقلت إِليه، للاشتراك الذي فيه والعموم وكثرة
ما يدخل تحته، أَو ما يخيل منه عرض بعيد، أَو ما يخيل منه زمان غير الزمان
الذي وجد فيه المعنى. فإِن هذه كلها أَسماء باردة. فمثال الاسم المشترك
المنقول أَن يسمى اللبن: الأَبيض، فإِن " الأَبيض " يقال على أَشياء كثيرة
بيض، فيعسر فهم ما يراد بذلك. وكذلك الشيءُ الذي ينقل إِليه اسم جنسه.
وأَرسطو يحكي عن بعض القدماء أَنه كان يستعمل أَمثال هذه الأَسماء
الباردة، فكان يسمى العرق " رطوبة " باسم جنسه، وكان يسمى الشهوة "
الاقتداء المنكوس من النفس " ، ويسمى عناية النفس " الاكتئاب " . وأَما
الذي يخيل زمانا غير زمان، فمثل أَن يدل على الفعل المستقبل بالكلمة
الماضية، أَو على ما وجوده في غير زمان بالكلمة الدالة على الزمان. فهذه
الأَصناف لا ينبغي أَن تستعمل في الخطابة. وهي تستعمل في الشعر، أَعني
التي تخيل في الشيءِ عرضا بعيدا. والأَسماءُ المنقولة أَول أَمرها تكون
غريبة. وهي حينئذ أَخص بالشعر. فإِذا تمادى الزمان بها وصارت مشهورة،
وصلحت للخطابة. فإِن اشتدت شهرتها، عدت في أَصناف المستولية. وهي بالجملة
إِنما ينبغي أَن تستعمل في هذه الصناعة في أَحد موضعين: إِما عندما ليس
يلفى للشيءِ الذي فيه القول اسم، فينقل إِليه اسم آخر، وإِن لم يقصد به
أَن يستمر على طول الزمان؛ وإِما عندما يراد أَن يسمى به ذلك الشيء في
الزمان المستقبل على جهة الشريعة للناس. والذي ينبغي أَن يستعمل هاهنا
منها ما كان تفهيمه المعنى بسهولة، ويخيل فيه حالا بمقدار ما يحتاج إِليه
في هذه الصناعة، لا ما كان منها غامضا. فإِن الغموض لا ينبغي أَن يستعمل
مع من يقصد به تبصيره؛ وإِنما يستعمل مع من يقصد به أَن يغمض عليه المعنى.
ولا ما كان منها أَيضا يخيل في المعنى أَمراً أَعظم مما قصد إِليه
والأَسماءُ المركبة خاصة بأَصناف الأَشعار الطويلة الممدودة لكثرة الحروف
التي منها تركبت. والغريبة خاصة بالأَشعار التي تقال في الأُمور العظام
التي يقدم عليها مع توق وحذر، مثل الحروب. فإِن الأَسماءَ الغريبة تعطي في
الشيءِ تفخيما وتعظيما. وأَما الأَسماءُ المغيرة فتليق من أَصناف الأَشعار
بالأَشعار التي يقصد بها الالتذاذ وجودة التفهيم. وهذا يقال في صناعة
الشعر.
وأَما الصنف الرابع من الأَلفاظ الباردة فيكون في التغييرات التي ليست
بجميلة. وذلك يعرض فيها من وجوه: إِما أَن تكون من أَشياء بعيدة، وإِما
أَن تكون من أَشياء قريبة، وإِما من أُمور ظاهرة، وإِما من أُمور خفية،
وإِما من أُمور تخيل في الشيءِ زيادة مفرطة، أَو نقصا مفرطا، وإِما من
أَشياء خسيسة، وإِما أَن يتركب أَكثر من واحد من هذه الأَنواع. ولن تعسر
على من تفقد الخطب والأَشعار مثالاتُ هذه الأَنواع.
والمثال هو نوع ما من أَنواع التغيير. وذلك أَن من التغيير ما
يكون إِلى المثال وإِلى الشبيه. وإِنما الفرق بينهما أَن في التغيير يقام
المثال مقام الممثل به، وفي التمثيل يؤتى بحروف التشبيه. والمثال بالجملة،
أَعني المخترع أَو الموجود، والتغيير المثالي ينبغي أَن يكون أَمرا مناسبا
للمعنى الذي استعمل بدله، وبخاصة متى استعمل التغيير في أَشياء متباينة.
مثل ما حكى أَرسطو أَن الشعراءَ كانوا في زمانه يسمون المشتري، ذا الكؤوس،
وكانوا يسمون المريخ، ذا المجَن. وذلك أضنه لما كانوا يعتقدون أَن المشتري
كوكب الأُلفة والمحبة والصداقة والصفح، والناس إِنما تكون بأَيديهم الكؤوس
وهم بهذه الحال، استعاروا لبه هذا الاسم المناسب، لاعتقادهم فيه هذا
الاعتقاد. ولما كان المريخ عندهم كوكب الحروب والتباغض والتقاطع، وكان
الناس إِنما تكون بأَيديهم المجان والترسة عند الحروب، استعاروا له هذا
الاسم. فهذان التغييران إِذن مناسبان، إِلا أَنهما من أُمور بعيدة،
وأَرسطو يرى أَن تكون التغييرات الجميلة المثالية من الأُمور التي هي
واحدة بالنوع، وذلك بأَن يشبه الإِنسان بالإِنسان المناسب له مثل أَن يشبه
الجميل بيوسف. فإِن لم تكن واحدة بالنوع، فتكون واحدة بالجنس القريب. مثل
تشبيه العرب المرأَة الحسناء بالظبية. فإِن لم يكن، فبالجنس البعيد مثل
تشبيههم المرأَة الحسناء بالشمس. وأَما إِذا كان التغيير من أُمور لا
ترتقي إِلى جنس واحد - وإِن كان بعيدا - فهو رديء.
فهذا هو جملة ما قيل في الأَلفاظ المفردة التي ينبغي للخطيب أَن يستعملها.
ثم هو بعد هذا يذكر من أَحوال الأَلفاظ المفردة و المركبة أَشياء غير التي
سلفت وذلك أَن الأَحوال التي سلف ذكرها للأَلفاظ هي أَحوال لها من حيث هي
مخيلة. وأَما الأَحوال التي يذكرها بعد فهي الأَحوال التي إِذا اقترنت
بالأَلفاظ كانت أَتم دلالة وأَبين إِفادة وإِفهاما، أَو الأَحوال التي هي
ضد هذه، فيشير باستعمال تلك، وتجنب هذه.
قال: إِن أَول ما يحتاج إِليه الخطيب أَن يتأَدب بلسان القوم الذين هو
خطيب بلسانهم ويتعلمه، حتى تكون مخاطبته في جميع أَقاويله على أَفضل ما
جرت به عادة أَهل ذلك اللسان.
فأَول الأَشياء التي يجب أَن يتحفظ بها ليكون القول أَتم دلالة
وإِفادة للمعاني وضع حروف الرباطات في المواضع التي يجب أَن تكون فيها من
القول. والروابط هي بالجملة الحروف التي يرتبط بها القول وتتصل أَجزاؤه
بعضها ببعض. وقد عدد أَبو نصر أَصنافها في غير ما موضع. فإِن منها ما شأنه
أَن يوضع في أِول القول مثل الروابط التي تتضمن إِيجاب معنى لمعنى مثل
حروف الشرط والمجازاة، ومثل حروف الاستفهام والشك. ومنها ما شأنه أَن يوضع
في وسط القول مثل الواو والفاء وثم. ومنها ما شأنه أَن وضع في آخر القول
وهي حروف العلة والسبب، مثل قولك: أَكرمت زيدا لجوده. فإِنه أَفصح في كلام
العرب من أَن تقول: لجوده أَكرمت زيدا، أَو أَكرمت لجوده زيدا. وذلك بين
في لسانهم. فينبغي للخطيب أَن يرتب هذه الروابط في المواضع التي بها يكون
الكلام أَفصح في ذلك اللسان. وأَيضا فإِن من الروابط ما يقتضي أَن يتصل
باللفظ الذي يتصل به الرباط لفظ آخر غير الذي قرن به الرباط، وهذا يسمى
جزاء وقضاء. ومن شأَن هذا المتصل في بعض المواضع أَن يكون قبل الرباط، ومن
شأَنه في بعضها أَن يكون بعد الرباط. فينبغي أَن يوضع حرف الجزاء في
أَمثال هذه الأَقاويل في المواضع التي شأنها أَن توضع، وذلك إِما متقدما
للفظ المتصل باللفظ الذي يقترن به الرباط، وإِما متأخرا. مثال ما يكون
الجزاءُ فيه متأَخرا عن اللفظ المقترن بالرباط قولك: أَما زيد فمنطلق،
وأَما عمرو فقاعد. وأَما استعمال القول الذي يقتضي الجزاء والقضاء محلولا
دون روابط، فينبغي أَن يجتنب. وإِذا استعمل ذلك فينبغي أَلا يباعد بين
الجزاءِ وبين المجازى به بكلام كثير يدخله أَثناء ذلك. وأَيضا فإِن من
الرباطات ما يقتضي أَن يكون بعده رباط آخر، وذلك إِما من نوعه بأَن يتكرر
الرباط نفسه مثل إِما المكسورة، وإِما من غير نوعه مثل أم التي تأتي بعدها
هل في الاستفهام. فينبغي في أَمثال هذه المواضع أَلا يدخل بين الرباط
الأَول والثاني رباط آخر ليس شأنه أَن يقع بينهما. فإِن هذا يجعل القول
متعلقا غير مفهوم. وقد يحسن أَن يدخل بين الرباط الأَول والثاني في مواضع
يسيرة رباط آخر غريب، مثل قول القائل: أَما أَنا فلأجل كذا فعلت كذا وكذا،
وأَما فلان فلأجل كذا فعل كذا وكذا. فيحسن دخول الرباط الدال على العلة،
وهو قولك لأَجل كذا بين أَما الأُولى وأَما الثانية التي تقتضي إِحداهما
الأُخرى. وقد يؤتى بالرباط الغريب في مثل هذا الموضع في أَجزاءِ القول،
كقول القائل: أَما فلان ففعل كذا، وأَما فلان ففعل كذا وكذا، ولأَجل كذا
وكذا.ويعسر إِعطاء قانون يعرف أَين ينبغي أَن ترتيب أَمثال هذه الرباطات
الغريبة في موع موضع من أَجزاءِ أَمثال هذه الأَقاويل. وانما ينبغي أَن
يتحرى في ذلك ما يكون القول به أَتم إِبانة في الكلام. وكذلك قد يصلح في
مواضع يسيرة أَن يباعد بين الرباط وبين جزائه. فهذه هي أُول الوصايا التي
أَوصى ها من أَراد أَن يتأَدببلسان أُمة ما حتى يقومه.
والوصية الثانية: أَن يتوخى الخطيب أَن يكون كلامه بالأَسماءِ الأَهلية
الخاصة بالأَمر المقول، أَعني المتواطئة، لا بالأَسماءِ العامة المحيطة.
والوصية الثالثة: أَلا يكون الكلام بالأَسماءِ المشككة التي توهم الشيءَ
وضده وتضلل السامع. وهذه الأَسماءُ هي خاصة بالسوفسطائية، وهي بصناعة
الشعر أَخص منها بهذه الصناعة.
قال: والكهان إِنما كانوا ينطقون بأَمثال هذه الأَسماء،لأَن الوقوف على
خطائهم، إِذا نطقوا بمثل هذه الأَسماء، يقل، لاحتمالها معنى أَكثر من
واحد، كما عرض لرجل من الكهان مع بعض الملوك، فإِنه قال: إِذا عبرت النهر
الفلاني، أَتلفت رياسة عظيمة، فظن ذلك أَنها رياسة بعض أَعدائه. فلما عبر
النهر ظفر به عدوه وهلك، فكان الذي أَتلف رياسة نفسه. فإِذا نطقوا
بالأَسماءِ الأَهلية - أَعني الكهان - وحددوا الوقت والكمية فإِن الخطأ
يعرض لهم كثيرا.
والوصية الرابعة: أَن يتحفظ بأَشكال الأَلفاظ الدالة على المذكر
والمؤنث فلا يستعمل شكلا دالا على التذكير في المعنى المؤنث، ولا شكلا
دالا على التأنيث في المعنى المذكر. والتذكير والتأنيث في المعاني إِنما
يوجد في الحيوان، ثم قد يتجوز في ذلك في بعض الأَلسنة، فيعبر عن بعض
الموجودات بالأَلفاظ التي أَشكالها أَشكال مؤنثة وعن بعضا بالتي أَشكالها
أَشكال مذكرة. وفي بعض الأَلسنة ليس يلفي فيه للمذكر والمؤنث شكل خاص،
كمثل ما حكي أَنه يوجد في لسان الفرس. وهذا يوجد في الأَسماءِ والحروف.وقد
يوجد في بعض الأَلسنة أَسماء هي وسط بين المذكر والمؤنث، على ما حكى أَنه
يوجد كذلك في اليونانية. ويحتاج مع هذا في هذه الأَسماءِ أَن تكون
نهاياتها مشكلة بالأَشكال التي بها جرت عادة أُولئك القوم، أَعني أَن تكون
معربة بالإِعراب الذي جرت به عادة أَهل ذلك اللسان أَن يعربوا نهايات هذا
الصنف من الأَسماءِ في موضع موضع من القول أَو مبنية بالبناءِ الذي يخصها.
والوصية الخامسة: أَن يتحفظ باستعمال أَشكال الأَسماء الدالة على الواحد
والإِثنينية والكثير. ويتحفظ بأَصناف الأَسماء الدالة على الكثير، وذلك
أَن منها ما يدل على العشرة فما دونها مثل صيغة أَفعل في الجمع، كقولك بحر
وأَبحر وجبل وأَجبل، ومنها ما يدل على الكثير، كقولك جبال وبحار. فإِن
أَبنية هذه الأَسماء مختلفة. فينبغي للخطيب أَن يتحفظ بها وأَن يستعمل كل
شكل منها في موضعه، وأَن يجعل نهاياتها في القول مختلفة، كما قلنا،
بالاختلاف الذي جرت به عادة أَهل ذلك اللسان عند اختلاف أَحوال القول، وهو
الذي يسمى الإِعراب عند نحويي العرب، والاستقامة عند نحويي اليونانيين.
ووصية سادسة: وهو أَنه ينبغي أَن يكون الكلام المكتوب مما يسهل تفهم معناه
عند قراءته؛ ويكون المتلو مما يسهل تفسيره. والكلام المقروء إِنما يسهل
تفهم معناه في وقت قراءته بأَن تكون فيه علامات للاتصال والانفصال. وذلك
شيء لم يوضع بعد في خط لسان العرب. وهو موجود في كثير من خطوط سائر
الأَلسنة. والكلام المتلو الذي يعسر تفهم معناه هو الكلام الكثير
الرباطات، وهو الذي يعرف بالكلام المعقد. فإِن استعمال الرباطات في الكلام
ينبغي أَن يكون مقدراً. فإِن عدمها في الكلام جملة يوجب عدم فهم اتصاله،
كما أَن كثرتها توجب عدم فهم الانفصال. ومن ذلك أَن يتجنب في الأَقاويل
المركبة الأَلفاظ التي إِذا نطق بها لم يدر هل تتصل بالجزءِ الأَول من
القول أَم بالجزءِ الأَخير، مثل قول القائل: إِن هذه الكلمة إِذا كانت
بالديمومة تكون للرجل الحكيم. فإِن قولنا بالديمومة يحتمل أَن تكون من صفة
الكلمة حتى يكون تقدير ذلك أَن هذه الكلمة إِذا كانت بالديمومة فإِنها
تكون للرجل الحكيم؛ ويحتمل أَن يكون قولنا بالديمومة من صفة الرجل الحكيم،
فلا يكون القول تاما ويحتاج إِلى جواب، ويكون التقدير: أَن هذه الكلمة
إِذا كانت للرجل الحكيم بالديمومة، فيحتاج إِلى خبر. وسبب هذا الإِشكال
عدم علامة الاتصال والانفصال.
ومن ذلك: إِذا اتفق أَن كان شيئان داخلين تحت جنسين، فأَردنا العبارة عن
كل واحد منهما بما يخصه، فينبغي أَن نجعل العبارة عن كل واحد منهما باللفظ
الذي يخصه. وإِن أَردنا أَن نجمع بينهما جعلنا العبارة عنهما بما يعمهما.
مثال ذلك: إِذا أَردنا أَن نعبر عن فعل البصر بما يخصه قلنا أَبصرنا.
وإِذا قلنا عن فعل السمع قلنا سمعنا. فإِن أَردنا أَن نجمع بينهما قلنا
أَحسسنا. فإِن عبرنا عن فعل البصر فقط أَو السمع فقط بالإِحساس، كانت تلك
عبارة رديئة.
ومما يعسر فهم الأَخبار عن شيء يُقصد الإِخبار عنه أَن يُدخل المخبر بين
الخبر والمخبر عنه كلاماً كثيرا، مثل قولك: إِني كنت مزمعا حين تكلمت فكان
هاهنا كذا وكذا بحال كذا وكذا على أَن أَفعل كذا وكذا. يريد أَني كنت
مزمعا حين تكلمت على أَن أَفعل كذا وكذا فإِدخال مثل هذا في الوسط مما
يعسر به تفهم المعنى. إِلا أَنه قد ينتفع به في الخطابة، عندما يريد
الخطيب تكثير القول وغزارة الأَلفاظ. وذلك أَنه لو أَتى بمثل هذا الحشو
أَخيراً، لتبين على المكان أَنه فضل. فإِذا أَتى به في الوسط أَوهم
السامعين أَنه مما يحتاج إِليه. وأَما إِذا كان الخطيب قصده الإِيجاز فليس
ينبغي أَن يأتي بمثل هذا الحشو.
ومما ينفع في جودة تفهيم المعنى وتكثير القول - إِذا كان مقصوداً
للخطيب - أَن يستعمل الأَقاويل الشارحة مكان الأَسماء المفردة. وأَما إِذا
كان قصده الإِيجاز، فينبغي أَن يستعمل ضد ذلك. وقد ينتفع الخطيب بهذا
الإِبدال، أَعني إِبدال القول مكان الاسم، والاسم مكان القول. فإِنه إِذا
كان الشيء له صفة قبيحة، فالواجب على الخطيب أَن يبدل مكان ذلك القول
الدال على الصفة الاسم. وكذلك إِن كان الاسم يخيل في المعنى قبحا، فينبغي
أَن يبدل بالقول المساوي له. واستعمال الأَقاويل بدل الأَسماء مما ينفع في
تكثير القول. والأَقاويل المبدلة بدل الأَسماء هي التي تؤلف من أَغراض
الشيءِ والأَفعال الصادرة على جهة الخزاية. والقول المبدل قد يمكن أَن
يجعل قصيرا، ويمكن أَن يكون طويلا. والأَقاويل المبدلة شعرية أَكثر ذلك،
وقد يتجنبها الشعراءُ، وذلك بحسب ما يقصد من إِطالة القول واختصاره. فقد
يقصد الشاعر وصف شيء واحد فيجعل بدله أَقاويل كثيرة؛ وقد يقصد وصف أَشياء
كثيرة فيجعل بدلها قولا واحدا، إِذا أَراد الاختصار. وربما جعل بدل كل
واحد منها قولا إِذا أَراد الإِطناب.
ومما يصير به القول مختصراً أَن يجعل غير مربوط بعضه ببعض. والقول الغير
المربوط هو الذي إِذا ابتدئ به أَردف بما ليس من شأنه أَن يتصل به بل
يحتاج أَن يدخل بينه وبين الذي أَردف به متوسط. فإِذا حذف ذلك المتوسط،
كان القول غير مربوط حتى يخيل أَن القول الأَول من غير جنس الثاني. وهذا
هو من نمط الكلام الذي يعرف بالفصول. وهذا النوع من الكلام الغير المربوط
ليس يعدم فيه حروف الروابط. وإِن كان قد يكون نوع آخر من الكلام غير مربوط
من جهة عدم حروف الروابط فيه أَصلا على ما تقدم. فيكون القول الغير
المربوط صنفين: صنف عدم حروف الرباط، وصنف عدم المتوسطات التي بين أَجزاءِ
القول.
قال أَبو نصر: ويكاد أَن يكون خطباءُ العرب يرون أَن البلاغة إِنما هي
استعمال القول الغير المربوط.
وأَما الأَلفاظ المعدولة والأَسماءُ الغير المحصلة والكلم الغير المحصلة،
وبالجملة السلوب كلها والأَلفاظ التي تدل على العدم لا على ذوات
الأَشياءِ، فإِنما ينبغي أَن تستعمل أَكثر ذلك عند التعريض، وعند إِرادة
إِخفاءِ الشيءِ وستره، وهي شعرية أَكثر منها خطبية، وبخاصة ما كان منها
مفرط الدلالة، فإِنها لا تدل على شيء محصل. فلذلك إِن استعملها الخطيب في
المدح أَو الذم، لم يذم بشيء محصل ولا مدح بشيء محصل. فلذلك لا ينتفع به
الممدوح ولا يستضر به المذموم ذلك الضرر. وكذلك أَيضا قل ما ينتفع به في
المشوريات ولا في المشاجريات. اللهم إِلا في الاعتذار فإِنه قد ينتفع به.
قال: والمقالة إِنما تكون جميلة إِذا كانت بأَلفاظ مخيلة، خلقية، موجهة
نحو الأَمر المقصود، معتدلة. وأَعني بقولي خلقية أَي بأَلفاظ تحث على
الخلق الذي شأنه أَن يصدر عنه ذلك الفعل الذي يقصد المتكلم الحث عليه.
فإِن هاهنا أَلفاظا يحث بها على الأَخلاق والانفعالات النفسانية، مثل
قولهم: أَلا رجل يفعل كذا وكذا، وهلا كان كذا وكذا. وأَعني بقولي موجهة
نحو الأَمر المقصود أَن يكون الخلق أَو الانفعال الذي يحث عليه مما شأنه
أَن يصدر عنه ذلك الفعل المقصود. وأَعني بقولي معتدلة أَلا تخيل في
المخاطب أَخلاقا هي أَرفع جدا منه، فيقل تخلقه أَو انفعاله عن ذلك القول،
ولا أَخلاقا هي أَخس منه جدا، بل تخيل فيه أَخلاقا تليق به. ومما يصير
القول خسيسا أَن يعبر عنه بالأَلفاظ الأَهلية المستولية، ولا يعبر عنه
بالكلية، بل بأُمور مفصلة. وبالجملة ينبغي أَلا يقتصر من الأَلفاظ على أَن
تكون مزينة بالنغم فقط أَو بسائر الأُمور التي من خارج، وهي التي تعرف
بالأَخذ بالوجوه، بل ينبغي أَن تكون مع هذا في نفسها مخيلة. والأَقاويل
الخلقية إِذا كانت مذكّرة بالعار والمنقصة كانت محركة للغضب. وإِذا كانت
مذكرة بالآلام وتعظيم الشيءِ كانت باعثة على التوقي والحذر والتعسر في
الشيءِ وأَلا يعطى المرءُ من نفسه ما يطلب منه. وإِذا كانت بالمديح كانت
مستدرجة نحو الشيء المقصود فعله ومسهلة له، وإِذا كانت بما يضاد المديح
كانت محركة للهم والجزع.
والأَقاويل الخلقية إِنما تكون مقنعة إِذا دل عليها بأَلفاظ دالة
بصيغها على الحث على الأَخلاق، لا بأَلفاظ لا تدل بصيغتها على ذلك الخلق،
ولا على ذلك الانفعال. وإِنما تكون الأَقاويل الخلقية أَشد إِقناعا
بالأَلفاظ الخاصة بها، لأَنه بهذه الأَلفاظ تتمكن من النفس، ويحسن موقعها
منها، فيظن بها أَنها الحق. إِذ من خاصة الحق أَن يتمكن من النفس، ويحسن
موقعه منها، فتغلط النفس في هذا، ويضللها موضع اللاحق. وأَيضا فإِذا كان
السامع قد ينفعل عن المخاطب له بالانفعالات التي من خارج مثل انفعالات
الوجه وغير ذلك من الأُمور التي قد عددت، فكم بالحري أَن ينفعل أَو يتخلق
من قبل الأَلفاظ التي تدل بصيغتها على ذلك الخلق أَو الانفعال.
وقد تبين مما قيل أَن الأَخلاق والانفعالات تشاكل كل جنس وهمة وأَعني
بالجنس مثل الغلام والشيخ والمرأَة والرجل والعربي والرومي، وأَعني بالهمة
الشيءَ الذي هو مقصود لأُمة أُمة من الأُمم في حياتهم الدنيا مثل الحكمة
عند قوم، والمال عند قوم آخرين، واللهو عند آخرين، وغير ذلك من الأَشياءِ
التي يمكن أَن تفرض غاية قصوى. والصنائع أَيضا والمهن لها تأْثير في
الاستعداد لقبول خلق خلق، وانفعال انفعال، فينبغي للخطيب أَن يتحرى اللاحق
لكل إِنسان من الأَخلاق والانفعالات فيحثه عليه. فإِنه إِذا تعمد ذلك، كان
فعله أَبلغ. ومما ينبغي له أَن يقصده: وهو أَن يخاطب أَهل كل صناعة
بالأَلفاظ الخلقية التي هي مشهورة عند أَهل تلك الصناعة، مثل أَن يخاطب
الحكماءَ بالأَلفاظ الخلقية التي هي مشهورة عند الحكماءِ، وكذلك في صناعة
صناعة. فإِن هذا الفعل له موقع عظيم في الإِقناع. والأَقاويل الخلقية ليست
هي الأَقاويل الانفعالية، ولا المواد التي تعمل منها هي واحدة بعينها.
وإِن كان قد يوجد عن الخلقية شيء من الانفعال، مثل قول القائل: ومَن لا
يعرف هذا؟ كل الناس يعرفون هذا. فإِن هذا قد يقر به السائل استحياءَ من
أَن يسئل كيف وجب ذلك. والاستحياء انفعال ما. فيستعمل الأَقاويل الخلقية
في الموضع اللائق بها، والانفعالية في الموضع اللائق بها أَيضا.
وينبغي للخطيب قبل ذلك فيما بينه وبين نفسه أَن يتقدم فيروّى في الطرق
والوجوه التي بها يقنع السامعين، فإِن بذلك يكون إِقناعه أَبين وليس يذهب
عنه ما يريد أَن يتكلم فيه.
وقد أَوصى الجدلي بمثل هذه الوصية في المقالة الثامنة من طوبيقى. وليس
ينبغي للخطيب أَن يجعل أَقاويله كلها بأَلفاظ من جنس واحد، حتى تكون كلها
بأَلفاظ مستعارة أَو غريبة أَو مشهورة، بل ينبغي أَن يخلط ذلك، فإِن بذلك
يكون القول أَشد تخييلا، لأَنه إِذا أَتى بها من جنس واحد، ولم يكن منها
شيء غريب، لم يفد ذلك غرابة ولا تعجبا يحرك النفس، وإِنما يظهر فضل القول
المخيل على القول المشهور، إِذا قرن به. وكذلك القول الغريب. فإِذا أَتى
بها كلها من جنس واحد أَشبهت المألوف. ولم تكن هنالك غرابة تحرك النفس.
والأَقاويل الانفعالية إِنما ينبغي أَن يستعمل فيها من الأَسماء
الغريبة والموضوعة والمضاعفة، فهي لذلك أَوفق. وذلك أَن هذه الثلاثة
الأَنواع من الأَلفاظ تخيل أَمراً زائدا على المقصود بها. فإِذا عبر عنها
بالأَقاويل الانفعالية أَفادت فيها معنى زائداً على الأَمر في التحريك نحو
الشيء الذي يبعث على الانفعال بما أَعطت في ذلك الشيء من التخييل. وينبغي
للخطيب عندما يستعمل الأَقاويل الخلقية والانفعالية مع السامعين في فعل
شيء ما أَو باجتنابه أَن يحكم عليهم أَنهم سيفعلون ذلك الشيء الذي يطلبون
به مع تحريكهم لذلك الخلق أَو الانفعال الذي من شأنه أَن يحرك نحو ذلك
الشيء، وذلك إِذا استدرجهم إِما إِلى فعل ذلك الشيء وحثهم عليه بالمدح
بالأَقاويل الخلقية، أَو التحريك إِلى المحبة بالأَقاويل الانفعالية،
وإِما لكفهم عنه وحثهم على اجتنابه بالذم بالخلقيات، أَو بالتحريك إِلى
البغضة بالانفعاليات. مثال ذلك أَن الإِنسان إِذا أَراد أَن يحرك إِنسانا
ما نحو فعل ما بالأَقاويل الخلقية. فإِن ذلك يمكن فيه بالمدح لمن شأنه أَن
يصدر منه ذلك الفعل، مثل أَن يقول له:هذا إِنما يفعله ذوو الهمم الرفيعة
والأَحساب الشريفة. فإِذا استعمل معه مثل هذا القول، فينبغي له أَن يزيد
في ذلك: وأَنت ستفعله، فإِن همتك وشرفك يقتضي ذلك. ومثل هذا يفعل إِذا
حركه بالأَقاويل الانفعالية، مثل أَن يقول له: إِنما يفعل هذا من يكتسب
الذكر الجميل ومودة الناس وأَنه سيكتسب ذلك. ومثل هذا يكون في اجتناب
الفعل بالذميات أَو المبغضيات. وهذا الفعل يسميه أَرسطو الإِنباء، ويقول
إِنه ينبغي للخطيب أَن يستعمل الإِنباء، ويقول إِن السبب في وقوع الإِقناع
به هو أَن الذي يخبر عنه أَنه سيكون إِنما يخبر عنه ومن شأنه أَنه سيكون.
ويقول إِن هذا الفعل يشاكل الشعر جدا، لأَن الشاعر بمنزلة النباء، أَعني
الذي يخبر بما يكون في المستقبل. وإِذا كان الإِنباء مع مزاح أَو هزل كان
أَحرى أَن يفعل في السامع. ولما كان قد تكلم من أَحوال الأَلفاظ المركبة
في كيفية تركيبها وترتيبها وطولها وقصرها، وأَعطى في كل واحد من هذه
الوجوه الوصايا النافعة، شرع يتكلم في الأَزمنة التي بين أَجزاءِ القول
الخطبي، فقال: إِن الكلام الخطبي ينبغي أَن يكون غير ذي وزن ولا عدد، يعني
بقوله غير ذي وزن، أَلا تكون الأَزمنة التي بين أَجزاءِ المقاطع أَو
الأَرجل أَزمنة يحدث عنها إِيقاع وزني، ويعني بقوله ولا عدد، أَلا تكون
حروف الأَرجل والمقاطع متساوية. وإِنما يكون القول موزونا إِذا جمع هاتين
الصفتين. والأَزمنة بين المقاطع والأَرجل ربما كانت سكنات ووقوفات على ما
عليه الأَمر في أَوزان العرب، وربما كانت مركبة من سكنات ونبرات على ما
عليه الأَمر في أَوزان سائر الأُمم. وإِنما لم يكن الوزن مقنعا في
الأَقاويل الخطبية لثلاثة أَشياء: أَحدها: أَنه يقع في نفس السامعين أَن
القول قد دخلته صناعة ما وحيلة حتى يظن أَن الإِقناع إِنما أَتى من قبل
الصناعة لا من قبل الأَمر نفسه.
والثاني: أَن يظن به أَنه قصد به التعجيب والإِلذاذ واستفزاز السامعين
بذلك، فيقع القول عندهم موقع ما قد غولطوا في الإِقناع به.
والثالث: أَن القول الموزون إِذا ابتدأَ القائل بصدره، فهم منه السامع عجزه للمناسبة التي بينهما والمشاكلة قبل أَن ينطق به القائل. وإِذا نطق به بعد، فكأَنه لم يأت بشيءٍ لم يكن عند السامع قبل، فيقل لذلك إِقناعه. ولما كانت الأَقاويل المركبة على ثلاثة أَصناف: إِما أَقاويل موزونة وهي التي يجتمع فيها الإِيقاع والعدد، وإِما أَقاويل لا يكون بين أَلفاظها المفردة أَزمنة، فينتهي بها كل لفظة منها عند السامع، أَو علامات تدل على ماهيتها. وهذا هو الذي يعرفه أَرسطو باللفظ السخيف. وإِما أَقاويل تكون بين أَلفاظها المفردة أَحوال تنهيها عند السامع وتفصلها، وذلك إِما بسكنات أَو نبرات. إِلا أَنها ليست نبرات تجعل القول موزونا فإِن الوزن إِنما يتم بالنبرات والوقفات التي تكون بين المقاطع والأَرجل وبالعدد، أَعني أَن تكون حروف المصرع الأَول في البيت مساوية لحروف المصرع الثاني. وكأَن قد ظهر أَن الأَقاويل الموزونة ليست بمقنعة، فكذلك يظهر أَيضا في الأَقاويل التي ليس بينها نبرات - بل هي متناسقة - أَنها قليلة الإِقناع. وذلك لسببين: أَما أَحدهما فلأَن الأَلفاظ إِذا لم يكن بينها فصول زمانية عسر فهم تلك المعاني، لأَنها إِذا وردت مشافعة في الذهن، لم يتمكن الذهن من فهم واحد منها حتى يرد عليه آخر، شبيه ما يعرض لمن يحب أَن يتناول شيئا من أَشياء سريعة الحركة، فإِنه لا يتمكن منها. وأَما الثاني فإِن القول يكون بها غير لذيذ المسموع، لأَنه إِنما يلتذ السمع بالنبرات والوقفات التي بين أَجزاءِ القول. وأَيضا فلكون الفصول التي في أَمثال هذه الأَقاويل متساوية لتقاربها فهي مملولة، لأَن اللذة إِنما هي في الانتقال من جنس إِلى جنس. وإِذا كان هذا هكذا، فلم يبق أَن تكون أَجزاء القول الخطبي إِلا القسم الثالث من الأَقسام وهو الذي يكون بين أَجزائه نبرات ووقفات لا تخرج القول إِلى أَن يكون بها موزونا. وبالجملة إِنما ينبغي أَن تكون النبرات والفصول في القول الخطبي بقدر ما تتمكن النفس من فهمه، وذلك لا شك مختلف باختلاف الأَقاويل. فإِن من الأَقاويل ما ينبغي أَن يباعد بين أَجزائها، ومنها ما لا ينبغي أَن يفعل ذلك فيها أَكثر. والنبرات تستعمل إِما في إِبعاد ما بين الأَقاويل وإِما في إِبعاد ما بين الأَلفاظ المفردة، وإِما في إِبعاد ما بين الأَرجل والمقاطع، وإِما في إِبعاد ما بين الحروف. والتي تستعمل منها في إِبعاد ما بين الأَرجل والمقاطع تخص الوزن الشعري. والتي تستعمل منها في إِبعاد ما بين الحروف تخص الأَغاني. فإِن الذي يخص الأَقاويل الخطبية من ذلك ما كان مستعملا في إِبعاد ما بين الأَلفاظ المفردة والأَقاويل.
والأَقاويل صنفان: منها قصار، ومنها طوال؛ ومنها التام، ومنها
غير التام. والتام منها أَدل، وهو القول الحازم، والأَمر والنهي، وسائر ما
يدخل تحتها، ومنها ثوان، وهو الخطب. فالنبرات يستعملها الخطيب في أَحد
ثلاثة مواضع: إِما في نهاية الأَلفاظ المفردة والأَقاويل القصار التي تقرب
من الأَلفاظ المفردة، وإِما في نهاية الأَقاويل القصار التي هي أَجزاءُ
الأَقاويل الطوال، وإِما في أَطراف الأَقاويل التامة بالوجه الثاني أَو في
أَنصافها، أَعني في أَجزاءِ الخطبة الكبرى. فالتي يستعمل منها في نهاية
الأَقاويل القصار جدا والأَلفاظ المفردة تضارع الكلام الموزون لقرب مساواة
الأَلفاظ المفردة والأَقاويل القصار للمقاطع والأَرجل. ولذلك ينبغي للخطيب
أَن يتوقى عند استعمال هذه النبرات أَن يصير الكلام موزونا. وذلك أَنها
متى وقعت بين المقاطع والأَرجل كان القول موزونا؛ ومتى وقعت بين الأَلفاظ
المفردة والأَقاويل القصار كان القول موزونا وزنا خطبيا. وكثيرا ما يعرض
في الخطب أَن تقع هذه النبرات أَو السكنات عند الأُمة التي تستعمل السكنات
أَكثر ذلك موضع النبرات بين المقاطع والأَرجل من غير أَن يقصدوا ذلك،
فيكون القول موزونا وهم لا يشعرون. وإِنما يصح للخطيب هذا النوع من الوزن
إِذا اختار من الأَلفاظ المفردة أَو الأَقاويل القصار ما يقرب أَن يكون
مساويا للمقاطع والأَرجل. والذي يستعمل منها في أَجزاء الأَقاويل القصار
التي هي أَجزاءُ الأَقاويل الطوال إِنما يستعمل ليدل على انفصال قول من
قول. وهذا إِنما يستعمل في الأَقاويل التامة بالتمام الأَول فيما أَحسب
وهي ضرورية في جودة التفهيم. وهذا الصنف من النبرات هو قليل، إِذ كان
إِنما يقع في نهايات الأَقاويل القائمة بأَنفسها. وهذه فيما أَحسب هي التي
تسمى عند العرب مواضع الوقف. فإِن العرب إِنما تستعمل أَكثر ذلك عوض
النبرات وقفات. والصنف الثالث يستعمل في ابتداء الأقاويل وفي ختمها وفي
توسطها لموضع الراحة. وهذه النبرات التي تستعمل في هذه المواضع الثلاثة
عند الأُمة التي تستعملها منها ما يبتدئ فيها بمقاطع ممدودة وتنتهي بمقاطع
مقصورة، ومنها ما يبتدئ بمقصورة وتنتهي بممدودة، ومنها ما تكون كلها
ممدودة. والتي تكون من مقاطع ممدودة تشاكل الوسط لموضع الراحة. وينبغي أَن
تعلم أَن الوقفات إِذا أُقيمت مقام النغمات صار القول باردا، وأَن عادة
العرب في النغم قليلة. والنغم إِنما تحدث إِما مع المقاطع الممدودة أَو مع
الحروف التي تمتد مع النغم وتتبعها كالميم والنون. وأَما المقاطع المقصورة
فقد تمد عند الحاجة إِلى استعمال النبرات فيها، إِلا أَن العرب يستعملون
النبرات بالنغم عند المقاطع الممدودة، كانت في أَوساط الأَقاويل أَو في
أَواخرها. وأَما المقاطع المقصورة فلا يستعملون فيها النبرات والنغم إِذا
كانت في أَوساط الأَقاويل. وأَما إِذا كانت في أَواخر الأَقاويل فإِنهم
يجعلون المقطع المقصور ممدودا. وإِن كان فتحة أَردفوها بأَلف، وإِن كان
ضمة أَردفوها بواو، وإِن كان كسرة أَردفوها بياء. وذلك موجود في نهايات
الأَبيات التي تسمى عندهم القوافي. وقد يمدون المقاطع المقصورة في أَوساط
الأَقاويل إِذا كان بعض الفصول الكبار ينتهي إِلى مقاطع مقصورة في أَقاويل
جعلت فصولها الكبار تنتهي إِلى مقاطع ممدودة، مثل قوله تعالى " ويظنون
بالله الظنونا " . وبالجملة إِنما يمدون المقطع المقصور عند الوقف قال:
وينبغي أَن يكون بين النبرات والنغم التي يستفتح بها القول وبين التي يختم
بها تضاد، مثل ما حكاه أَرسطو أَن الأَقاويل التي كان يستفتح بها عندهم
كان يبتدأُ فيها بحرف طويل أَو مقطع ممدود، وينتهي بثلاثة مقاطع قصار،
والتي يختم بها ضد ذلك، أَعني أَنها يبتدأُ فيها بثلاثة مقصورة وينتهي
بمقطع ممدود أَو حرف ممدود: لأَنه إِذا انتهى بمقطع مقصور جعل الكلام
مبتورا.
وليس ينبغي أَن يعتمد في نهاية الكلام المكتوب - إِذا تلي - على الفصول
التي في الخط، بل إِنما ينبغي أَن يعتمد على النبرات الفاضلة، وينطق بها
حتى يتبين نهايات القول.
فهذا هو القول في النبرات وبأَي حال يستعمل في نوع نوع من أَنواع الكلام
نوعٌ نوعٌ منها.
قال: وينبغي أَن تكون الأَقاويل الخطبية مفصلة إِما بأَن تكون
أَواخرها على صيغ واحدة بأَعيانها، وإِما بأَن تكون - مع كونها على صيغ
واحدة بأَعيانها - أَواخرها حروف واحدة بأَعيانها، وهو الذي يعرف عندنا
بالكلام المفقر، وإِما بلفظ مكرر بعينه، وتكون مع هذا موصلة بحروف
الرباطات. فمثال المفصل بالصيغ المتفقة قول تعالى: " فاصبروا صبرا جميلا.
إِنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا " . وذلك أَن جميلا وبعيدا وقريبا هي كلها
على صيغ واحدة وشكل واحد. وهذا كثير في الكتاب العزيز. وأَكثر الكلام
البليغ لا يخلو من هذين النوعين من التفصيل، أَعني المفقر وغير المفقر.
قال: والكلام المفصل هو الذي لا تنقضي فصوله قبل انقضاء المعنى الذي يتكلم
فيه. فإِنه إِذا انقضت الفصول قبل انقضاء المعنى كان غير لذيذ في السمع،
من أَجل أَنه لم يتناه بعد بتناهي الفصول. والسامع إِنما يتشوق النهاية.
ويعرض للمتكلم بهذا الكلام أَنه يقف عند انقضائها قبل انقضاء المعنى، فيقف
في غير موضع وقف. أَعني إِذا كان المعنى أَطول من الفصول. وإِذا جعل
المتكلم نهاية فصول القول بحسب نهايات المعنى لم يعرض له هذا.
قال: والكُرُور والمعاطف في الأَقاويل الخطبية هو أَن يكون أَول القول
وآخره بلفظ واحد أَو قريب من الواحد، وهذا مثل قولهم: القتل أَنفى للقتل.
ومثل قوله تعالى " الحاقة ما الحاقة وما أَدراك ما الحاقة " . والتكرير في
الكلام الخطبي إِنما يكون في هذه المعاطف. والكلام الذي بهذه الصفة إِذا
كان ذا قدر معتدل كان لذيذا سهل الفهم. أَما لذيذ، فلأَنه على خلاف الذي
لا يتناهى؛ وأَما سهل التعلم، فلأَنه يسهل حفظه لتكرر الأَلفاظ فيه، ولأَن
له عددا ووزنا.
قال: والكلام الموزون يحفظه كل أَحد، ولذلك صار الكلام المعطف أَسهل للحفظ
من جميع الكلام.
قال: وينبغي أَن تكون العطوف متناهية بانتهاءِ المعاني كالحال في الفواصل.
قال: وينبغي أَن تكون الوُصل في الكلام المفصل غير متراخية جدا ولا
متلاحقة، بل تكون بحيث يسهل التنفس في فصوله وأَقسامه، كالحال في الكلام
المعطف، أَعني أَنه لا يجب أَن يكون الجزءُ الأَخير منه منفرجا ولا
متراخيا عن الجزءِ الأَول. ولذلك كان الكلام الموصل هو قول تام منفصل يحسن
التنفس، أَي الوقف، في فصوله وأَقسامه.
قال: وينبغي أَن تكون فصول الكلام وأَعطافه لا قصارا ولا طوالا. أَما
القصار فإِن قصرها يكون سببا للسهو عنها والغفلة؛ وأَما الطوال، فلأَن
الطول يكون سببا لترك الإِصغاء إِليهم ومفارقة السامعين لهم بترك الإِقبال
عليهم كالذين يتعدون الغاية ويمشون في طريق طويل، فإِنه يعرض للذين
يصحبونهم أَن يفارقوهم. وكذلك يعرض أَيضا في المعاطف، إِذا كانت طوالا،
أَن تكون مملة. وكذلك إِذا كان أَيضا ما بين المعاطف طويلا، مثل قول
القائل: ما فعل فلان شرا، ولكنْ فلان الذي فعل كيت وكيت وكيت هو الذي فعل
الشر، فيباعد ما بين المعطفين. وأَما القول الذي فصوله قصار جدا فلا يفعل
فعل الكلام المعطف ولا فعل الكلام المفصل لأَن السامعين لها يسنخفون بها
ويستهزئون بها، فتنبو عنها أسماعهم.
قال: والكلام الموصل بحروف الرباطات منه ما هو مقسم من غير أَن يكون بين
أَقسامه تضاد، مثل قول القائل: أَما فلان فقال كذا وكذا، وأَما فلان فعمل
كذا وكذا. ومنه ما هو مقسوم إِلى أَشياء متضادة أَو موجودة لأُمور متضادة.
مثال ذلك في الأُمور المتضادة أَنفسها، قول القائل: أَما العقلاء
فأَنجحوا، وأَما الحمقى فأَخفقوا. ومثال ذلك في لواحق الأُمور المتضادة
قول القائل: أَما فلان فمشتاق إِلى الكسب، وأَما فلان فمشتاق إِلى اللهو،
لأَن الاشتياق إِلى الكسب هو لازم للفقر، والاشتياق إِلى اللهو لازم
للثروة.
قال: والكلام الذي بهذه الصفة لذيذ، وذلك أَن الأَشياءَ المتضادة تكون
أَعرف إِذا وضع بعضها حيال بعض، وذلك أَنها تعلم بوجهين بذاتها وبزيادة،
أَعني بمقايستها إِلى الضد. وفي ذلك أَيضا بجهة ما استدلال على الشيء. فهي
بهذه الجهة تشبه الاستدلال على الدعوى.
قال: ومن الكلام الموصل: المتدافع وهو الذي لا تكون أَجزاؤه ذوات
الفصائل أَو العطوف متساوية، بل يكون بعضها أَطول من بعض، ولكن يكون
الطوال منها والقصار منتظمة، وذلك مثل ما يحمده الكتاب عندنا من أَن تكون
الفقرة الثانية أَطول من الأُولى.
قال: ومنه أَيضا الكلام المضارع، وهو أَن تكون أَجزاؤه الموصولة متشابهة،
وذلك إِما في أَول الفصول أَو في أَواخرها. والتشابه في أَوائل الفصول
يكون أَبدا بالأَسماء، مثل قول القائل: السعادة حركته، والسعادة أَنجدته،
ومثل قولهم، طويل العماد، طويل النجاد. وأَما التضارع بالنهاية فيكون
بالمقاطع، أَعني بالحروف التي تسمى الفِقر، ويكون بتصاريف الاسم، ويكون
باللفظ الواحد بعينه. أَما المتشابهة النهاية والتصريف يحتمل أَن يريد بها
المتفقة أَشكال أَلفاظها، ويحتمل أَن يريد التي أَلفاظها مشتقة بعضها من
بعض، مثل قول القائل: إِنه يمكر وأَمكر، ويكيد وأَكيد. وكلاهما يحدث في
الكلام إِلذاذا. وأَما الذي يكون باللفظ الواحد بعينه فكثير أَيضا، مثل
قول القائل: إِن رأيه مصيب، وإِن فعله مصيب.
قال: وإِذ قد حددت هذه الأَشياء، يعني الأَحوال التي توجد للأَلفاظ من جهة
ما هي مركبة، فقد ينبغي أَن نقول من أَين تؤخذ الأَقاويل الحسان المنجحة
الفعل. فإِن شأن هذه الصناعة إِنما هو أَن يفعل الإِقناع حسنا جيدا،
فنقول: إِن مبدأَ الأَمر في ذلك هو أَن تكون الأَلفاظ المستعملة فيها جيدة
الإِفهام لذيذة عند كل أَحد. والأَلفاظ، فهي دالة على شيء. فما كان منها
يفعل مع الدلالة جودة الإِفهام والإِلذاذ، فهي التي تفعل جودة الإِقناع.
وليس يصلح لهذا الفعل الأَسماء التي من اللغات الغريبة، لأَنها مجهولة غير
جيدة الإِفهام. ولا يصلح أَيضا لذلك الأَسماء المبتذلة المشهورة، لأَنها
وإِن كانت جيدة الإِفهام، فإِنها غير لذيذة. فإِذن ليس كل إِبدال وتغيير
يصلح لهذه الصناعة، وإِنما الذي يصلح لها من التغييرات ما وجدت فيه هذه
الزيادة، أَعني جودة الإِفهام مع الإِلذاذ. وهذا التغيير هو مثل قول
القائل: إِن الشيخوخة هي فاعلة الخيرات، بدلا من قوله: إِن الشيخ هو فاعل
الخيرات. فهذا تغيير، ولكنه مفهم، لأَنه من الجنس. والشيخ إِنما هو فاعل
للخيرات من قبل الشيخوخة.
قال: وفعل اللفظ في هذا شبيه بفعل المثال والضمير، أَعني أَنه قد يوجد
فيهما ما يفعل جودة التفهيم والالتذاذ، وقد يوجد فيهما ما يفعل التفهيم
دون الالتذاذ. ولذلك أَيضا كانت التغييرات المركبة الاستعارة والبعيدتها
أَقل إِلذاذ من غيرها، لأَنها تكون طويلة كاذبة، أَعني قليلة الإِفهام.
وذلك أَن ما يعرض من ذلك شبيه بما يعرف في المثال المركب البعيد، فكما أَن
النفس لا تتشوق إِلى التمثيل بمثل هذا ولا تلتذ، كذلك يعرض لها أَلا تلتذ
بالاستعارات البعيدة المركبة. وإِذا كان هذا هكذا، فمن الواجب أَن تكون
الأَلفاظ الحسان المستعملة في هذه الصناعة والاحتجاجات الحسان ما اجتمع
فيه الأَمران جميعا، أَعني الالتذاذ وجودة الفهم.
قال: ولهذا لا ينجح في هذه الصناعة فعل الذين يفعلون الضمائر فيها
والمثالات من الأَشياءِ البينة جدا المكشوفة لكل أَحد التي لا يحتاج أَحد
أَن يفحص عنها. وكانت أَمثال هذه معدودة في الاستدلالات السخيفة. وكذلك
ليس ينبغي أَن يكون المعنى أَيضا مما إِذا قيل لم يفهم، أَو عسر تفهمه،
كما أَنه ليس ينبغي أَن يكون إِذا قيل معروفا من ساعته، ولا أَن يكون مما
هو واجب أَن يكون، لكن يكون مما يضلل الفكر قليلا، أَعني أَنه يحصل فهمه
بعد تأَمل يسير. وذلك أَن الأَمر البين من ساعته قد يكون منه قياس، لكن
يكون غير لذيذ؛ كما يكون من الأَلفاظ الحقيقية التي ليست مستعارة إِفهام،
لكن غير لذيذ. فقد تبين من هذا أَن الضمائر والمثالات المنجحة في هذه
الصناعة إِنما هي التي تؤلف من أَمثال هذه المعاني، وأَن الأَلفاظ المنجحة
هي المغيرة، أَعني المستعارة، تغييرا يفعل الالتذاذ. والتخييل مثل التغيير
الذي يكون من الضد، أَعني أَن نسمي الشيءَ باسم ضده على جهة التحسين له،
مثل تسمية الحرب سلما. وكما يجب أَن يتجنب التغيير الذي يكون من الأَسماء
الغريبة، كذلك ينبغي أَن يجتنب التغيير الذي يكون من الأَسماءِ المشتركة.
فإِن الاسم المشترك يعسر فهمه، مع أَنه ليس فيه شيء من التخييل.
قال: وبالجملة: فينبغي للمتكلم في الشيءِ على طريق البلاغة أَن
يجعل الشيءَ الذي يتكلم فيه كأَنه مشاهدٌ بالبصر. وذلك بوصفه أَفعاله
الواقعة أَو المتوقعة. والإِعتماد في جعل الشيء كأَنه نصب العين يكون
بثلاث أَشياءِ: أَحدها التغيير الحسن، والثاني وضع مقابله حذاءه، والثالث
وصف الأَفعال الواقعة والمترقبة الوقوع. ومثال وصف الأَفعال والإِتيان
بالمقابل، قوله تعالى: " وبشروه بغلام عليم. فأَقبلت عليه امرأَته في صرة
فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم " .
ووصف الأَفعال كثير في كلام البلغاءِ وأَشعار المغلقين، مثل قول النابغة:
سقط النصيف ولم ترد إِسقاطه ... فتناولته واتقتنا باليد
ومثل قول أَبي تمام:
أَعيدي النوح معولة أَعيدي ... وزيدي من عويلك ثم زيدي
وقومي حاسرا في حاسرات ... خوامش للنحور وللخدود
ومثل ما جمع الأُمور الثلاثة قول القائل:
إِذا ما هبطن الأَرض قد مات عودها ... بكين بها حتى يعيش هشيم
قال: فأَما التغييرات المنجحة التي تفضل غيرها في ذلك فهو التغيير الذي
يكون من الأَشياءِ المتناسبة، يعني إِذا كان هاهنا شيء نسبته إِلى شيء
نسبة ثالثٍ إِلى رابع، فأُخذ الأَول بدل الثالث وسمي باسمه، وذلك مثل ما
قال بعض القدماءِ يذكر الشبان الذين أُصيبوا في الحرب إِنهم فقدوا من
المدينة كما لو أَنَّ أَحداً أَخرج الربيع من دور السنة.
ومثل قول أَبي الطيب:
مغاني الشعب طيبا في المغاني ... بمنزلة الربيع من الزمان
وذكر في هذا أَمثلة كثيرة من أَقاويل مشهورة كانت عندهم يعسر تفهم القول
بها بحسب لساننا وعادتنا.
والاستعارة التي تكون من هذا النوع كثيرة موجودة في أَشعار العرب وخطبها.
والأَقاويل التي يخصها أَهل لساننا من الناظرين في الشعر والبلاغة
بالاستعارة هي داخلة في هذا الجنس، ولذلك يقولون: إِن المجاز استعارة
وتشبيه.
قال: وينبغي للخطيب أَن يحتال بكل جهة لتكثير صفات الشيء الصغير إِذا تكلم
فيه، فإِن كثرة الأَوصاف هي من التكثير والتعظيم، وذلك مثل قول القائل
يُحسن السلم: إِن السلم من أَعلام الغلبة والنجح، وهو أَفضل من الحرب،
لأَن الغلبة والنجح فيه أَوحى وأَسرع ودون تكلف ومشقة. وأَما الحرب فإِنما
تكون الغلبة فيها والنجح بعد استكمالها وتكلف المشقة وذهاب النفوس
والأَموال في ذلك. فكلاهما من أَعلام الغلبة والنجح، لكن أَحدهما أَيسر
وأَوحى.
قال: وينبغي إِذا أَردنا أَن نجعل الشيءَ بالقول نصب العين أَن نبين ماذا
يفعل وما الذي يلزم تلك الأَفعال، أَعني أَن نذكر الأَشياءَ التي هي
أَفعال ودلائل.
قال: والتغيير نفسه قد يفعل الأَمرين جميعا، أَعني أَنه يجعل الشيءَ نصب
العين وينبئ عن ماذا يكون منه، لكن لا يتضمن ذكر الأَفعال. ولذلك ينبغي
أَن يستعمل التغيير في الأَفعال أَنفسها بأَن تخيل أَفعال ذوات الهمة
والكرم، وبالجملة: أَفعالا منسوبة إِلى الحرية وكرم النفس، كما يقال زهري
الأَفعال، وحاتمي الكرم، وذلك بحسب ما يحتاج إِليه في موضع موضع.
قال: ومن الجيد في التغيير الذي يكون في الأَفعال، أَعني إِذا وصفت مغيرة،
أَن تجعل الأَشياء التي توصف أَفعالها، إِذا كانت أَفعالها غير متنفسة،
متنفسة حتى يخيل في أَفعالها أَنها أَفعال المتنفسة. وذلك مثل ما كان
يفعله أُوميروش. وذكر في ذلك مثالات من قوله. وهذا مِثل قول المعري:
تَوَهَّمَ كلَّ سابِغَة غديراً ... فَرَنَّقَ يشرب الحِلَقَ الدُّخالا
ومثل قول أَبي الطيب:
إِذا ما ضربتَ به هامة ... براها وغنَّاك في الكاهل
وهذا كثير في أَشعار العرب، أَعني جعلها الاختيار والإِرادة لغير ذوات
النفوس.
قال: والتغيير المستعمل في الأَفعال التي للمتنفسة قد يستعمل على
جهة المناسبة والمعادلة في غير المتنفسة، مثل ما يقال في ترك الاستحياء
والوقاحةِ، إِذ كانت هذه أَيضا أَفعال يذم بها، إِن الذي لا يستحي وعنده
الذي يجب أَن يستحي منه بمنزلة الحجر عند الإِنسان. وهو عكس الأَول. فإِنه
قد يكون مثل هذا التغيير، أَعني الذي بالمعادلة والمناسبة، في الأَمثال
المنجحات في هذه الصناعة، وإِن كان في غير المتنفسة، أَعني أَنه يتمثل في
المتنفسة بغير المتنفسة على جهة المعادلة، مثل ما يقال: إِن الفلاحين من
المدينة بمنزلة الأَساس من الحائط، وإِن المقاتلة فيها بمنزلة الشوك من
القنفذ، وإِن فلانا لقي من فلان مرارة الصبر وحلاوة الشهد، وذلك أَن معنى
هذا أَنه لقي منه خلقا نسبته إِلى الخلق المكروه نسبة مرارة الصبر إِلى
الأَشياءِ المرة.
قال: وبالجملة فينبغي أَن يكون التغيير المستعمل في الأَفعال مثل التغيير
الذي وصفنا أَنه يجب أَن يستعمل في الأَشياء أَنفسها، أَعني في ذوات
الأَفعال، وذلك بأَن يؤتى بالأَلفاظ المعتادة التي ليست معروفة كل المعرفة
ولا أَيضا مجهولة كل الجهل، بل متوسطة فيما بين ذلك. فإِنه كما أَن
استعمال الشبيه إِنما يكون نافعا جداً في الفلسفة، وفي هذه إِذا توخى
مستعمله فيه أَن يكون بهذه الحال الوسطى من الجهل والمعرفة، كذلك الأَمر
في الأَلفاظ أَنفسها.
قال: وقد يقع الإِقناع اللذيذ بالتغيير الذي يستعمل في الشيءِ على جهة
الغلو والإِفراط، وذلك إِذا كان الأَمر الذي كان منه التغيير عجيبا بديعا
إِلا إِنه كذب بين، مثل قولهم: هي ضرة الشمس وأُخت الزهرة أَو أَجمل من
الزهرة وأَعلى موضعا من الشمس.
قال: وهذا النحو من التغيير هو مذموم في الخطب المكتوبة، يعني الرسائل.
قال: وقد يكون التغليط من قبل التغيير الذي يكون بالأَلفاظ المغلطة لذيذا،
أَعني إِذا قصد المتكلم لتغليط السامع بها. وذلك يكون بوجهين: أَحدهما أَن
يريد أَن يقول قولا عليه فيه إِنكار، فيستعير له اسما مشتركا يقال عليه
وعلى معنى ليس فيه إِنكار عليه ويكون أَظهر في المعنى الذي ليس فيه عليه
إِنكار منه في المعنى المنكر،فيعرض للسامع عند ذلك أَن يغلط فيغلب ظاهر
اللفظ، ويأتي المتكلم بذلك في صورة من لا يتكلم في شيء وهو يتكلم فيه.
وهذا مثل ما قيل في اليهود إِنها كانت تقول للنبي عليه السلام: راعنا،
توهم بذلك أَرعنا السمع، وهي تريد غير ذلك، حتى نهى المسلمون عن هذه
اللفظة. والوجه الثاني أَن يأتي بلفظة مشتركة تقال على معان بعضها كاذبة
ومنكرة وبعضها صادقة، إِلا أَن دلالة اللفظ فيها هو على السواءِ أَو هو في
الكاذبة أَظهر منه في الصادقة، وهو يقصد به المعنى الكاذب دون الصادق.
فيمكن أَن يعتذر عنه بما تحت ذلك اللفظ من المعنى الصادق الذي لم يقصده،
مثل أَن يقول قائل في ثلب رياسة الحكمة: إِن رياسة العلماءِ ليست برياسة.
فإِن غلط في ذلك كان التغليط لذيذا، وإِن شعر بكونه كذبا، كان إِنكاره
لذيذا ومقنعا. وإِن أَتى بالكاذب بلفظ غير محتمل، فلما عيب عليه أَنكر، لم
يكن إِنكاره لذيذا ولا مقنعا. وهذا أَكثر ما يكون من قبل الأَلفاظ
المشتركة، وقد يكون من قبل قرائن الأَحوال، مثل قول القائل لمن ينافره: ما
أَبي بزان ولا أُمي بزانية. فإِن ظاهر القول أَنه نفى هذه الفواحش عن
نفسه، وقرينة الحال تدل على أَنه أَثبتها لخصمه، إِذ كان قد وضع خصمه ضده.
وثلب الضد يكون إِما بذاته، وإِما بمدح ضده. ولذلك اختلف الفقهاءُ في
إِيجاب الحد في أَمثال هذه الأَقاويل وهي التي يعرفونها بالكنايات.
قال: ومما يجانس هذا، أَعني التغيير اللذيذ أَن يؤتى بالواجب بلفظ
المستحيل، مثل قول القائل: إِنه يجب على المرءِ أَن يموت قبل أَن يستوجب
الموت. فإِن صورة لفظ هذا القول هو أَن الإِنسان يجب عليه أَن يموت وليس
مستوجبا للموت. وذلك كلام متقابل ومتناقض. لكن لما عبر بهذا القول الذي
صورته صورة القول المتقابل عن معنى حق، وهو أَنه يجب على المرءِ أَن يموت
قبل أَن يحدث جرما، كان بتلك العبارة أَلذ منه بهذه الأَلفاظ أَنفسها
لكوْن هذه أَهلية وتلك غريبة.
قال: وإِنما يحسن وقوع هذه المقالة متى قيلت بإِيجاز وبالمقابلة
بالتناقض، لأَن التفهيم يكون من طريق المقابلة التي فيه أَحْسَن، ويكون من
جهة الإِيجاز أَسرع.
قال: ويجب في هذا الموضع إِما أَن يقرب القول من المعنى حتى لا يخفى،
وإِما أَن يؤتى بالمعنى مستقيما، أَعني من غير أَن يؤتى فيه باللفظ
المقابل، وأَن يكون، مع هذا القول الذي يغير بهذا النحو من التقابل، صادقا
جدا، وليس فيه كذب أَصلا، وإِنما كان قول القائل: بأَن الواجب أَن يموت
قبل أَن يستوجب الموت أَحسن في السمع وأَلذ من قول القائل: إِن الواجب
علينا أَن نموت قبل أَن نحدث جُرْماً، من قبل أَمرين اثنين: أَحدهما تكرير
اسم الواجب في القول، والثاني الإِتيان بالمقابلة. وإِنما ينفق هذا الموضع
الذي ذكر، إِذا كان اشتراك في المتقابل الموضوع فيه، وكان المعنى المشترك
الذي قصد فيه، أَعني الذي ليس هو بمقابل، ظاهراً جدا. وهذا هو معنى قوله:
وينبغي أَن يقرب اللفظ من المعنى. وأَما إِذا كان خفيا في اللفظ فهو قبيح.
ومن هذا الموضع عيب على أَبي العباس التطيلي الأَندلسي قوله:
أَما والهوى وهو إِحدى الملل ... لقد مال قدك حتى اعتدل
حَكَى لنا بعض أَصحابنا أَن الأَديب ابن سراج عابه عليه وكلمه في ذلك،
فتمادى هو على استحسانه، علما منه بأَن الاعتدال يقال على استواءِ القامة
ويقال على الحسن وأَنه هاهنا مفهوم لمكان مقابله. وابن سراج إِنما عابه
لخفاءِ المعنى الذي قصده، وقلة استعمال هذا اللفظ عليه.
قال: وكما يكون التغيير في الأَفعال، كذلك يكون في الأَسماءِ وتكون فيها
أَنواع التغييرات التي وصفنا، أَعني التغيير من المقابل، والتغيير من
المناسب، والتغيير من الشبيه، والتغيير أَيضا بضرب الأَمثال. وهذه كلها
إِذا ما استعملت على ما قلناه أَنجحت في هذه الصناعة نجحا كثيرا. فمثال
التغيير الحسن على طريق المناسبة في الأَشياءِ أَنفسها التي ليست بمتنفسة
قولهم في الترس " صحفة المريخ " ، وفي القوس بلا وتر " رباب بلا شعر " .
هذا إِذا استعمل هذا التغيير على جهة التركيب، أَعني على جهة المناسبة.
وأَما إِذا استعمل على الإِطلاق، وهي جهة الشبه فقط لا جهة المناسبة، قيل
في الترس إِنه صحفة وفي القوس إِنه رباب.
قال: وقد يجمع في التشبيه والتغيير صورة الشيء وفعله، كما قيل: إِنه يشبه
قردا يزمر بأنبوب. والتشبيه إِنما يحسن جدا إِذا حسن أَن يوضع تغييرا
واستعارة. وأَما إِذا لم يحسن فيه ذلك كان بعيدا ومتكلفا.
قال: ولذلك قد يخطئ الشعراءُ كثيرا في أَن يأتوا بالتشبيه الذي لا يحسن
أَن يوضع للشيء على طريق التغيير، مثل قول القائل: إِن ساقيه جعدتان
كالكرفس.
قال: وضروب هذه التغييرات هي كلها أَمثال. والأَمثال المقولة بخصوص هي
تغييرات من الشيءِ إِلى الشبيه، فيستعملها المرءُ فيما يصيبه من خير أَو
شر، يريد مثل الأَمثال المضروبة في كتاب دمنة وكليلة ومثل الجزئيات
الواقعة التي ينقل القول الواقع فيها إِلى أُمور كثيرة لموضع الشبه، مثل
قولهم: ذكرتني الطعن وكنت ناسيا، وقد ساوى الماء الزبى؛ وبلغ الحزام
الطُّبيين.
قال: فأَما من أَين تؤخذ التغييرات الحسا ولأَيى علة تكون حسانا فقد تبين
من هذا القول. وهذا الذي ذكره هي مواضع الفصاحة وشروط الكلام الفصيح.
قال: والإِغرابات التي تنجح في هذه الصناعة من قبل التركيب الغير المعتاد
في الأَقاويل هي أَيضا تغييرات، يريد بحسب التركيب لا بحسب الأَلفاظ
المفردة، وذلك فيما أَحسب، مثل التقديم والتأخير والحذف والزيادة
والإِغرابات الغريبة.
قال: ومن التغييرات أَيضا الإِفراطات في الأَقاويل والغلو فيها، وهي تدل
من حال المتكلم على الفظاظة وصعوبة الأَخلاق والغضب المفرط، مثل قول
القائل: ولا لو أَعطيت مثل هذا الرمل ذهبا أَفعل كذا وكذا، وكما قال
بعضهم: ولا الزهرة الشبيهة بالذهب تعدل حسن هذه الفتاة. وهذا النوع من
الكلام كثير في كلام العرب وأَشعارهم.
قال: والأَقاويل الغير المكتوبة هي أَخص بهذا الجنس من التغيير.
وأَما استعمالها في الأَقاويل المكتوبة، وهي الرسائل، فيقبح.
فإِنه ليس ما يوافق الخطب الغير المكتوبة من هذه الأَشياء يوافق المكتوبة،
ولا ما يوافق من ذلك الخطب المشورية يوافق الخطب المشاجرية. ولذلك ما يجب
أَن يعرف ذلك، فنقول: إِن وكد المتكلم بالكلام البلاغي الغير المكتوب أَما
إِن كان متكلما فأَن يحسن الاستدلال والإِثبات، وإِن كان مجيبا فأَلا يضطر
إِلى السكوت والانقطاع. وأَما الأَقاويل المكتوبة، فينبغي أَن تكون أَشد
تصحيحا وتحقيقا من الأَقاويل الغير المكتوبة، لكون المكتوبة تبقى مخلدة
وتلك تنقضي بانقضاءِ القول فيها. والمنازعة والمشاجرة أَحوج إِلى الأَخذ
بالوجوه وهي بها أَخص، أَعني الانفعالي والخلقي. لأَن الأَخذ بالوجوه
نوعان: أَحدهما يوجب انفعالا ما من السامع، والآخر خلقا ما.
قال: والذين اعتادوا هذا النوع من الإِقناع يطلبون الكتب المثبتة فيها
أَنواع الأَخذ بالوجوه أَكثر من طلبهم الكتب المثبتة فيها أَنواع المعاني
والأَلفاظ. وهذا موجود في الصنفين جميعا، أَعني الشعراء والخطباء.
قال: والأَقاويل المسموعة تنسى ولا تثبت فلا يتوجه إِليها من النقد ما
يتوجه إِلى الأَقاويل المكتوبة، ولذلك ليس يلزم من تصحيحها ما يلزم من
تصحيح الأَقاويل المكتوبة. ولاختلاف هذه الأَنواع كان كثير من الكتاب
المجيدين إِذا حاولوا الإِقناع بالقول لا يجيدون الكلام، ومن الخطباءِ
أَيضا من يجيد الإِقناع من غير أَن يكون لهم حذق بالأَخذ بالوجوه بأَيديهم
وغير ذلك من جوارحهم. والعلة في ذلك أَنهم لم يزاولوا الأَقاويل الخصومية.
فإِن الأَقاويل التي تستعمل في الخصومات شديدة المشاكلة للأَخذ بالوجوه.
ولذلك إِذا طرحت منه، ظهر تكلم المتكلمين بها غير مستقيم. وذلك أَنه قد
يكون الكلام كثيرا فيها محذوف الرباطات ومكررا. وهذا غير جائز في المكتوب،
وهو جائز في الخصومات، وعند الأَخذ بالوجوه.
قال: والأَخذ بالوجوه إِذا خالطه التغيير اللفظي كان شديد التضليل للفكر
والإِقناع، وذلك أَن الأَخذ بالوجوه يتنزل من القول المغير منزلة الموطئ
والمستدرج. والمستعمل للأَخذ بالوجوه هو الذي يقدر أَن يبلغ بالتغيير من
الإِقناع أَقصى ما في طباعه أَن يبلغ به، لأَن الأَخذ بالوجوه يحدث
استجابة واستعطافا وأَما الذي لا يستعمل الأَخذ بالوجوه فكأَنه إِنما يسوق
إِلى الإِقناع قسراً.
قال: وكذلك الكلام المحذوف الرباطات لا بد فيه من الأَخذ بالوجوه، وأَلا
تقال تلك الأَلفاظ المحلولة بنغمة واحدة وهيئة واحدة، مثل قول القائل:
لقيته، أَردته.
قال: وخاصة الكلام الغير المربوط أَنه إِذا كانت أَلفاظه متساوية النطق
بها، أَعني في زمان سواء، فقد يظن بالقول الواحد أَنه كثير، لأَن الرباطات
تجعل الكثرة واحدة. وإِذا حذفت صار الواحد كثيرا. وذلك نافع حيث يراد
التعظيم والتكثير، مثل قول القائل: وردت. تكلمت. تضرعت؛ بدلا من قوله:
وردت فتكلمت وتضرعت. فإِنه إِذا حذف الرباط في هذا أَوهم أَنه عمل كثيرا.
وهذا قد يكون بالأَلفاظ المتقاربة المعاني وبتكرير الاسم الواحد بعينه
مراراً. وذلك أَنه إِذا كرر اللفظ الواحد بعينه أَوهم الكثرة في المعنى.
ومن هذا النحو هو استعمال الأَسماء المترادفة مثل قوله: أَقوى وأَقفر.
وذكر أَن أُوميروش كان يستعمل مثل هذا القول محذوف الرباطات.
قال: والخطب المشورية، فقد يجب أَن تكون صدورها شبيهة بالرسم الذي يرسمه
الزواقون للصورة قبل الصورة، يريد أَن يكون متضمنا للغرض المتكلم فيه
بالمعنى الكلي. وهذا كثيراً ما يتوخاه الكتاب والخطباء.
قال: والعلة في ذاك أَن الإِفهام يجب أَن تكون العناية به في خطب المحافل
والمجامع أَكثر منه في خطب الآحاد، لأَنه ينبغي أَن يكون الإِفهام فيها
بحسب أَنقصهم فهما، حتى يستوي الكل في الفهم. وأَما إِقناع الجمهور فيكون
بالمقنعات التي هي دون، بخلاف الأَمر في إِقناع الخواص
قال: وأَما الأَقاويل الخصومية فيجب أَن يكون الإِقناع فيها أَشد
تحقيقا وتصحيحا، ولا سيما إِن كان القول عند حاكم واحد، فإِن عمل الإِقناع
يكون أَيسر، لأَنه ليس يحتاج أَن يتكلف فيه من الاستعارات والتغييرات ما
يتكلف في الكلام الذي يكون عند الجماعة. وإِذا كان الإِقناع خليا من
الأَشياءِ خارجة كان أَقرب أَن يتميز فيه الحق من غيره، وأَن يكون الأَمر
الذي يتكلم فيه هاهنا أَهليا غير غريب، أَي معروفا غير منكر. وأَيضا فإِنه
إِذا استعملت في الأَقاويل الخصومية الأَشياء الخارجة، بَعُدَ الشاكي عن
غرضه. فلذلك ما ينبغي أَن تكون أَقاويل الخصوم أَقرب إِلى الحقيقة منها
إِلى التضليل. وإِنما ينجح فعل الخطيب بالتغيير اللفظي حيث يكون الأَخذ
بالوجوه والنفاق أَنفع من غيره، وذلك عند الخطب على الملإِ والجمع الكثير،
لأَنه ليس يطلب في مثل هذه الأَقاويل الصحة، كما يطلب عند الحكم الخاص.
قال: فأَما الخطب المرئية،. يعني المكتوبة، فمنها الرسائل، ومنها التي
تكتب عند الخصومات التي تكون بين أَيدي القضاة وهي التي تسمى عندنا العقود
والسجلات. فأَما الرسائل فالذي تختص به هو إِجادة القراءة، أَعني أَن تكون
قراءتها سهلة جيدة. وأَما التي تكون عند الخصومات فينبغي أَن تكون خلية من
التغيير والاستعارة البعيدة التي تجعل الكلام معتاص الفهم أَو مختلا، إِلا
أَن يكون يشتمل على ذكر أَمر مُهمٍ من خلق أَو عهدٍ أَو إِلزام سنة،
فينبغي حينئذ أَن يفخم الكلام ويعظم ويزين مثل السجلات التي تسمى عندنا
البيعات. وأَما المكتوبة في الخصومات فينبغي أَن تكون محققة بعيدة مما
يحقرها أَو يخسسها. فإِن السجلات أَشرف من الرسائل. لكن تكون جميلة بهية.
وإِن كان فيها إِضمارات كثيرة فليست محققة. وكذلك يجب أَلا تكون موجزة كل
الإِيجاز، فإِنها تكون غبر معلومة بل يجب أَن تكون متوسطة، لأَن المتوسط
أَبدا مشاكل مناسب.
قال: وقد يجب أَيضا أَلا تكون عَريا لا من التفصيل ولا من التغيير، لكن
يستعمل من ذلك ما هو أَقرب إِلى الشهرة والتحقيق منه إِلى الغرابة والجهل،
وتكون المقنعات التي فيها مؤلفة من الأُمور الجميلة المحمودة التي ذكرت
فيما سلف.
قال: أَما في الأَلفاظ الخطبية وفي المعاني فقد قلنا في ذلك ما فيه كفاية،
وهو أَمر عام لجميع أَجزاء الخطبة. والذي يعني القول فيه هو أَجزاءُ الخطب
ونظامها.
القول في أَجزاء الخطب
قال: وأَجزاءُ القول الخطبي الضرورية إِثنان: أَحدهما الغرض وهو الأَمر
الذي يقصد إِليه بالتكلم، فإِنه من الاضطرار أَن يذكر الشيء الذي فيه
القول ليعلم الشيء الذي يتوجه إِليه الإِثبات أَو النفي؛ والآخر التصديق،
وهو القول المثبت أَو النافي.
قال: وأَما الجزءُ الذي يسمى الاقتصاص الواقع في الخطب فهو خاص بالكلام
الخصومي. أَما الكلام المنافري والمشاوري فليس يستعمل فيه الاقتصاص، لأَن
الاقتصاص إِنما يستعمل فيما يلقي به الخصم، لا بالكلام البراني، أَعني
الموجه نحو السامعين.
قال: وأَما الجزءُ الذي يسمى الصدر، والجزءُ الذي يسمى الخاتمة فأَكثر
الحاجة إِليهما في الجزء المشاوري، لأَنه يقوم مقام تمثيل الشيء الذي فيه
يتكلم وتحديده أَولاً والتذكرة به آخراً، فيتحصل به الغرض الذي يتكلم فيه
تحصيلا جيدا. وذلك شيءٌ يحتاج إِليه في الكلام في هذا الجنس ليقايس بين
الحجج المثبتة له والمبطلة ولئلا يذهب المعنى أَيضا لكثرة تكرر القول
وتشعبه. وقد يحتاج إِلى الصدر في الكلام الخصومي، إِذا كان متشعبا يخاف
أَلا ينضبط فيه الغرض. وأَما إِذا كان الكلام قصيرا، فليس يحتاج إِليه.
وكذلك لا يحتاج إِليه في الأَقل في المشوريات، أَو يكفي منه اليسير.
قال: وإِذا كان الأَمر في هذه الأَجزاء كما وصفنا فالأَجزاء الاضطرارية
هما إِثنان: الغرض المقصود له، والتصديق. وجميع ما يلقى به الخصم فهو من
التصديقات.
قال: والخاتمة أَيضا تكثر في الخطب، لأَنها جزءٌ من أَجزاءِ التصديق، إِذ
كانوا يخبرون فيها بالشيء الذي فيه القول بإِجمال وبالشيء المقول فيه ليس
لأَن يثبتوا ذلك وليقولوا فيه قولا، بل على جهة التذكير بما قد تقدم فيه
فقيل.
قال: فإِذا عددت بالجملة أَجزاء القول الخطبي كانت خمسة: اقتصاص
بعد اقتصاص، وهي الخاتمة التي تُذكّر بالتصديق وبالغرض؛ واقتصاص قبل
اقتصاص، وهي رسم الغرض قبل الغرض؛ ورسم التصديق قبل التصديق، وهو القول
المثبت أَو النافي.
قال: ولكن ينبغي أَن توضع لهذه المعاني الخمسة - إِذ كانت مختلفة -
أَسماء، كما يفعله أَهل الصنائع، يريد أَن يسمي الجزء الأَول صدراً،
والثاني الغرض، والثالث الاقتصاص، والرابع التصديق، والخامس الخاتمة.
قال: والصدر هو مبدأُ الكلام، وهو الذي يستفتح به الكلام، ونسبته إِلى
الكلام نسبة فواتح الأَشياء إِلى الأَشياءِ، وذلك مثل فاتحة الزمر إِلى
الزمر، وما أَشبه ذلك. فإِن الفواتح مبادئ للأَشياءِ التي تأتي بعد،
وتدريجات لما يجيء منها واحدا بعد واحد.
قال: وفاتحة الزمر شبيهة بفاتحة الكلام المنافري. فإِنه كما أَن الذين
يزمرون بالأَنابيب، إِذا أَرادوا أَن يجيدوا الزمر، إِنما يترنمون به
أَولاً، ثم أَنه بأَخرة يضمون ويجمعون الزمر، كما ينبغي أَن يكون الذي
يتكلم بالكلام التثبيتي، أَعني المنافري، أَعني أَنه ينبغي للذي يريد أَن
يجيد قوله أَن يبين فيماذا يتكلم ثم يتدرج حينئذ إِلى سائر الكلام ويضم
ويؤلف. وهكذا نجد الخطباء يفعلون أَجمعين.
قال: والبرهان على وجود هذا المعنى للصدر، أَعني أَنه يضبط الغرض الذي فيه
القول ويحدده، صدر الكلام الذي لفلان حيث ابتدأَ فقال حين أَراد أَن يشرع
في ذكر امرأَة مشهورة عندهم ورجل مشهور: إِنه ليس هاهنا شيء يختص بذكر
فلانة دون فلان، بل هما فيه معا. وذلك أَنه إِذا فعل الخطيب هذا، لم يمكنه
أَن يروغ أَو يحيد عن الغرض الذي ذكره، فيأتي كلامه كله مستويا.
قال: وقد تُعمل صدور الكلام المشوري من المدح أَو الذم، كقول فلان في أَول
مقالته التي تدعى كذا حيث يريد أَن يمدح الذي يؤلفون من العيد: إِنه قد
يجب أَن يكثر التعجب من اليونانيين الحكماءِ.
قال: وكذلك الصدور التي في المشوريات هي أَيضا جزءٌ من المشوريات، مثل
أَنه إِذا أَراد أَن يشير بإِكرام قوم يبدأُ فيقول: إِنه ينبغي أَن يكرم
الخيار. وإِذا أَراد أَن يشير بذم قوم، افتتح الكلام: إِنه ليس يجب أَن
يمدح الذين لم ينجحوا قط ولم يصنعوا شيئا يظهر لهم به خير أَو فضيلة.
وكذلك الخصوميات تكون الصدور فيها من نوع الكلام الذي يقصد به السامع، لا
الخصم.
قال: وإِنما يضطر إِلى الصدور إِذا كان الكلام كثيرا، إِما من أَجل أَن
الأَمر المتكلم فيه عجيب، أَو من أَجل أَنه صعب، أَو من أَجل أَنه شغب
يكون فيه كالكلام الذي يكون في الامتنان بالعفو، وذلك مثل قول القائل في
ابتداء خطبة العفو: الآن رمى ما كان فكل شيء هدر.
قال: وبالجملة: فصدور الكلام: أَما التثبيتي فتكون من المدح والذم، وأَما
المشوري فمن الدعاء ولا دعاء، وأَما الخصومي فمن الشكاية التي يقصد بها
السامع.
قال: وينبغي أَن تكون حواشي الكلام إِما غرائب وإِما أَهليات، يريد - فيما
أَحسب - أَن يكون الذي يستفتح به الكلام إِما مثل غريب منبئ عن الشيء
المتكلم فيه، وإِما مثل مشهور، مثل أَن يستفتح الخطب التي يشار فيها
بالأَخذ بالحزم وحسن النظر أَو في التي يقصد بها الشكاية: قد بلغ السيل
الزبى، وجاوز الحزام الطبيين.
قال: والصدور ينبغي أَيضا أَن تستعمل في الكلام الخصومي، فإِنه يوجد لها
فيه الفعل الذي تفعله صدور الكتب والأَشعار. فإِن الصدر بالجملة إِنباء عن
الكلام المقصود، يراد به أَن يتقدم السامعون فيعلموا فيماذا يتكلم
المتكلم، وأَلا يكون للفكر تعلق في حين الكلام في معرفة الشيء الذي يتكلم،
مثل ما يعرض له في الكلام المهمل الغير المحدود، فيضلله ويغلطه. ولذلك ليس
الكلام الذي بهذه الصفة، أَعني الذي ليس له مبدأ يدل عليه، مثل الكلام
الذي يكون متبعا لمبدئه ومنبئا ومنبها عليه، مثل قول فلان لما أَراد أَن
يذكر فلان بأَفعاله ابتدأَ فقال: انبئيني عن الرجل الكثير المكائد الذي
حسم أُمور كثيرة من بعد ما خربت المدينة العامرة. وليس يفعل هذا الخطباء
فقط، بل والشعراء الذين يعملون المديح وغيرهم من أَصناف الشعراءِ.
قال: والعمل الخاص بالصدور الذي يوجد لها اضطراراً وهو غايتها
وتمامها إِنما هو أَن ينبئ عن الشيء الذي يتكلم فيه ما هو حتى يكون ذلك
الشيء معلوما منه وفيه. وإِذا كان الأَمر المتكلم فيه يسيرا، فليس يحتاج
إِلى التصدير.
قال: وقد يتقدم الكلامَ في الشيء وجوهٌ من الحيل التي وصفناها فيما تقدم
وهي خاصة ببعض الكلام، لا عامة. وتلك الوجوه من الحيل منها ما هي مأخوذة
من قبل المتكلم نفسه، ومن السامع، ومن الأَمر الذي فيه يتكلم، ومن الخصم.
أَما الذي يكون من قبل المتكلم ومن قبل خصمه، أَما في الشكاية فمدح نفسه
وتعظيمها وتنقص خصمه. وليس المتكلم والمجيب في تقديم الكلام في ذلك بحال
واحدة، لأَن المجيب ينبغي له أَن يبدأ بالجواب في إِنكار الشكاية، وأَما
الشاكي فينبغي أَن يبدأ بتقديم الكلام على الشكاية. وأَما المجيب فقد كفاه
الشاكي أَن ينبئ أَول كلامه عن الغرض، فلذلك ليس يحتاج إِلى تقديم الكلام.
وبالجملة فالذي يجيب على المجيب هو أَن يبادر إِلى دفع الشكاية عن نفسه
ويقطع عن ذلك جميع العوائق ولا يتوانى في ذلك ويؤخر تلك الأَشياء التي هي
حيل واستدراجات للحكام إِلى آخر كلامه. وأَما الشاكي فينبغي أَن تكون
شكايته بتقديم الكلام، أَعني التصدير، ليكون السامعون أَذكر للأَمر. وأَما
الحيل التي يبدأ بها مما هي نحو السامع فهي إِيجاب الشفقة عليه والمحبة له
والغضب على خصمه، وذلك بأَن يثبت عنده أَنه ذو قرابة منه أَو بينه وبينه
علاقة نسب، أَو بضد ذلك. فإِنه ليس في كل موضع ينفع تثبيت القراة
والمشاركة في النسب، بل ربما أَدى ذلك إِلى الضحك والسخرية ممن يدعي ذلك،
إِذا كان ما يدعيه غير معروف. ومما يستدرج به السامعون أَيضا بسطهم
وإِيناسهم، وذلك أَن البسط والإِيناس مما ينتفع به عند كل شريف من الناس
ونفيس. ويجب للذي يريد أَن يثبت أَنه خير وفاضل أَن يعتمد ذلك عند الذي
بينه وبينهم قرابة أَو صلة، وكذلك عند القوم الذين يكون مألوفا عندهم أَو
عجيب المنظر. فإِن لم يكن عندهم واحداً من هؤلاءِ، فقد ينبغي أَلا يشتغل
بالأمور التي من خارج، ويثبت - إِن كان مجيبا - أَن الأَمر الذي ادعى به
عليه يسير أَو غير مؤذٍ؛ وإِن كان شاكيا أَن يبين أَنه مؤذِ ومكروه عظيم.
وكل هذه الأَشياء هي خارجة عن الأَمر الذي يتكلم فيه، وهي كلها موجهة نحو
السامعين، أَعني الحيل الخارجة والصدور. فلذلك إِذا كان واجبا على المتكلم
أَن يصدر الكلام، فينبغي أَن يكون الصدر بقدر الكلام، فإِن الصدر إِنما هو
ليكون للكلام رأس كما للجسد.
قال: وأَما تثبيت الخطباء القرابة فإِنه عام لجميع أَجزاءِ الكلام الخطبي.
وذلك يكون في كل حال إِذا كان السامعون عالمين بالقرابة غير شاكين فيها.
قال: ومما يستحق فاعله الهوان أَن يكون التصدير بالأُمور الصعبة على
النفوس الكريهة المسموع، ولا سيما إِذا تأَمل السامعون أَو تفقدوا ما يكون
من ذلك، مثل قول القائل: إِنه لا يكون هذا حتى أُقتل، أَو أَنه ليس هاهنا
شيء هو لي أَكثر مما لكم، أَو أخبركم خبرا لم تسمعوا بمثله قط في الغرابة
أَو الشدة. ومن هذا النوع الذي ذكر تستقبح بداءآت كثير من الأَشعار مثل
استقباح عبد الملك بن مروان لاستفتاح جرير:
أَتصحو بل فؤادك غير صاح.
ومثل ما استقبح استفتاح أَبي الطيب:
أَوه بديل من قولتي واها.
وقوله:
كفى بك داء أَن ترى الموت شافيا.
وهذا كثير في أَشعار العرب وخطبها.
قال: أَما ما كان من هذه الأَشياء نحو السامع فبيّن، وأَما ما كان منها
نحو الأَمر نفسه فبين واضح من هذه الأَشياءِ. والذين يكثرون الصدور والحيل
التي نحو السامع إِنما يفعلون ذلك حيث يتشعب عليهم الكلام إِما لجهلهم،
وإِما لعدمهم الفضيلة، أَو للأَمرين جميعا. ولذلك الشرار أَو الذين يظن
بهم الشر قد يفعلون ذلك لأَن تطريقهم وتدريجهم للأُمور التي يتكلمون فيها
في كل حال هو أَمثل. ولذلك ما صار العبيد ليس يتكلمون في الشيء الذي
يُسئلون عنه، وإِنما يتكلمون في الأَشياء الخارجة عن الشيء الذي يُسئلون
عنه.
قال: فأَما من أَين ينبغي أَن يؤنس السامعون أَو يحتال لأُنسهم فقد قيل في
ذلك وفي غيرها من الانفعالات النافعة عند السامعين وكيف تكون إِجادة هذا
الفعل في المقالة الثانية من هذا الكتاب.
قال: والأَقوال المديحية يحتاج فيها أَن يجتهد في إِيهام السامع
ذلك الأَمر الذي يقصد تثبيته ويوقع عليه ظنه. وينبغي مع هذا أَن يمدح
المرء إِما بحضرته أَي بمدينته، وإِما بحضرة جنسه، أَو بحضرة من يتصل به،
فإِنه أَسرع لقبول مدحه. فإِنه كما قال سقراط: ليس يعسر أَن يُمدح أَهل
أَثينا عند أَهل أَثينا، وإِنما يعسر أَن يمدح عند أَهل لوقيا، يعني
أَعداءهم.
قال: وما كان من الكلام المشوري فهو يشبه الكلام الخصومي، فإِنه ليس يحتاج
فيه كثيرا إِلى تقديم كلام وتصدير، من أَجل أَن السامعين يعرفون الشيء
المتكلم فيه، إِلا أَن يكون محتاجا إِلى تقديم الكلام من أَجل نفسه، أَو
من أَجل الذين ينظرون في الكلام، إِذا لم يعلموا الأَمر الذي يتكلم فيه،
إِلا أَن يريد أَن يوهمهم أَن الشيءَ النازل به ليس خاصا به ولا صغيرا بل
هو عام وعظيم، أَو أَنه بضد هذا، أَعني خسيسا وصغيرا. والذي يحتاج إِليه
ضرورة في الخصومة هو القول في تثبيت الشكاية والاحتجاج لها والتكبير
والتصغير لها.
قال: وينبغي أَن ينظر في الأَشياء التي تتنزل من الأَقاويل الخطبية منزلة
التزويق والتزيين، وذلك كالذي يكون في الأَشياء المموهة التي يظن بها
أَنها بحالة ما، وليس هي كذلك بالحقيقة. وهذا قد يكون في المدح، ويكون
أَيضا في الاعتذار عن الشكاية. والشكاية بالجملة إِنما يقع الإِقناع بها
بأَن يثبت المرءُ الشاكي على أُولئك الذين يشكو بهم سوء الهمة أَو سوء
السيرة. والمشتكى منه إِنما يجيب بأَن يثبت أَنه لا فرق بين أَن يدعي هذه
الشكاية أَو لا يدعيها. وهذا هو أَحد المواضع التي يجيب منها المشتكي منه،
وذلك إِذا لم يعترف أَن الأَمر كان. فإِن الخصومات أَجمع إِنما تكون
المنازعة فيها من المدعى عليه إِما بأَن الأَمر لم يكن، وإِما بأَنه كان
وليس ضرراً ولا جوراً، وإِما أَنه ليس على هذه الصفة التي ذكر الشاكي كان
الفعل، وإِما أَنه لم يكن بهذا القدر الذي ذكره أَو أَنه ليس عظيما أَو
أَنه ليس قبيحا أَو ليس له خطر. ففي هذه ونحوها تكون المشاكسة والمنازعة
بين المتشاكسين والمتنازعين.
ومن هذه المواضع يقع الاعتذار أَما أَولاً فأَن يعترف أَنه أَضر ولكنه لم
يقصد ذلك ولا تعمده وإِنما قصد الجميل أَو النافع لا غير ذلك.
وموضع آخر: أَن يعترف أَنه أَضر ولكن بالإِكراه، لا بالطوع ولا بالاختيار
والإِرادة. وموضع آخر: وهو أَن يوجد الشاكي قد افترى الشكاية قَبْلُ على
إِنسان ليس متهما، أَو كان معروفا بالشكاية والافتراءِ. وهذا الموضع هو
بالجملة أَن يبين المجيب أَن الشاكي به غير موثوق وأَن كلامه غير مصدق
عليه. وموضع آخر وهو مأخوذ من دعوى مخالفة الباطن للظاهر لمصلحة يدعيها في
الفعل الظاهر: وهو أَن يدعي أَن ذلك الفعل منه لم يطابق ظاهره فيه باطنه،
وأَنه كان فيه كالمنافق لمصلحة يدعى في ذلك، مثل أَن يحنث في يمين ويدعي
أَن ظاهره كان في ذلك غير موافق لباطنه، وإِنه كان في ذلك كالمنافق لمصلحة
ما قصدها.
وموضع خامس: وهو أَن يدعى لذلك الفعل مقصدا أَو حكما غير الذي زعمه
الشاكي. وهذا الموضع والذي قبله يعمهما أَن يدعي أَن الفعل الواقع قصد به
غير الذي زعم الشاكي، وذلك بأَن يصف كيف كان وقوع ذلك الفعل. وموضع آخر
للذي يخجل من شيء يذكره: أَن يمدح قليلا ويذم كثيرا. فإِن الشكاية ليس في
وقوعها معرة من المذمومين، أَو يذكر منه فضائل كثيرة ثم يذمه من الجهة
التي افترى بها.
وهكذا يفعل أَهل الحذق والنفاذ والدَّهىْ، فإِنهم يقصدون أَن يضروا
بالخيار من الناس بأَن يصفوهم بالأَمرين جميعا، أَعني بالخير والشر، من
قبل أَن الشر ممكن وقوعه من أَهل الخير. ولو وصفوهم بالشر فقط، لم يكن ذلك
مما يظن بهم.
قال: والموضع المأخوذ من توجيه جهة الفعل هو عام للذي يخجل وللذي يتنصل
معا، لأَن الشيءَ الواحد يمكن أَن يفعل من أَجل علل شتى. فالذي يخجل يوجهه
إِلى الشر، والذي يتنصل منه ويعتذر يوجهه إِلى الخير.
قال: وأَما الاقتصاص فقد يكون في الجزءِ المنافري. وينبغي - إِذا كان
الاقتصاص إِنما هو تصديق ما موجز يتعجل وقوعه قبل التصديق التام - أَلا
يؤتى به على النسق والتركيب الذي يستعمل في الأَقاويل التصديقية، بل قد
يؤتى به مفردا وعلى غير نسق.
قال: وينبغي أَن يبين وجود الأَفعال التي منها تعمل الدلائل على
الأَشياءِ المقصودة التثبيت. وهذه الأَفعال منها ما يكون تثبيتها بالأُمور
الخارجة ومنها ما يكون بطريق صناعي، وهي المثبتة بالقول. ولأَن التثبيتات
تختلف: فمنها مشتبك متشعب، كتثبيتك في الفضائل الكثيرة أَنها موجودة
للمدوح، أَو للشيءِ الذي هو موجود له منها، أَو اَنه موجود له عدد ما
منها، أَو أَنه موجود له كل شيء منها. فقد ينبغي أَلا يكون الاقتصاص
الواقع في هذه الأَشياءِ على نسق، لأَن التثبيت الذي يكون على نسق مما
يعسر حفظه؛ بل ينبغي أَن يكون الاقتصاص في هذه على غير نسق ومجملا.
قال: وأَما إِذا كان الموصوف فإِنما ينفرد بفضيلة واحدة مثل أَن يكون
شجاعا أَو حكيما أَو ناسكا، فإِن التثبيت في مثل هذا يكون بسيطا. فأَما
الأَول فمشتبك وغير بسيط. وكأَنه يريد أَن الاقتصاص في المدح البسيط ليس
يخالف التثبيت في عدم التركيب والنظام، وإِنما يخالفه في ذلك في التثبيت
المركب، إِذ كان الاقتصاص من شأنه أَن يؤتى به بسيطا لا مركبا، أَعني أَنه
استدلال بسيط موجز لا مركب ولا منتظم، سواء كان التثبيت مما يحتاج فيه
إِلى التركيب والنظام أَو لا يحتاج.
قال: وليس ينبغي أَن يستدل على الأُمور المعروفة. ولذلك كثير من الناس ليس
يحتاج في مدحهم إِلى اقتصاص، وهم الناس الذين فضلهم بالجملة معروف، وإِنما
المجهول منها عند السامع تفصيلها. لأَن الاقتصاص إِنما يثبت فيها شيئا هو
معلوم. فأَمثال هؤلاءِ لا ينبغي أَن يشتغل فيهم بعمل الاقتصاص المجمل، قبل
التثبيت المفصل، مثل أَنه إِذا أَراد إِنسان أَن يمدح أَبا بكر وعمر رضي
الله عنهما، فليس يحتاج في مدحهم أَن يبين أَنهم أَفاضل قبل أَن يشرع في
تثبيت فضائلهم على التفصيل. اللهم إِلا أَن يكون الحاكم والسامع جاهلا
بالممدوح، مثل الغرباء؛ فإِنه قد يحتاج مع أَمثال هؤلاءِ إِلى استعمال
الاقتصاص.
قال: ولأَن المدح إِنما هو كلام ينبئ عن عظم الفضيلة، فقد ينبغي أَن
يستعمل المدح بالأُمور الخارجة التي ليست اختيارية على جهة التأكيد
للتصديق الواقع من قبل الأَفعال. فإِن المدح إِنما يكون بالأَفعال.
واستعمال الأَشياء التي من خارج على جهة التأكيد للمدح المتقدم بالأَفعال
هو مثل قول القائل، بعد تثبيت الأَفعال الفاضلة: وبالواجب كان هذا، فإِنه
يحق أَن يكون من الخيار خيارٌ، وإِن من نشأَ هذا المنشأ فحقيق أَن يكون
بهذه الحال. والمدح، كما قلنا، إِنما يكون بالأَفعال. والمفعولات هي دلائل
الأَفعال. وقد يمدح المرءُ وإِن لم يذكر له فعل وذلك إِذا تهيأَ وقوع
التصديق بأَنه سعيدٌ أَو مغبوط أَو أَنه فاضل. وذلك أَن المدح بالأَفعال
إِنما هو ليستدل به على الفضيلة. والمدح بالفضيلة ليستدل بها على السعادة
والغبطة. فإِن نسبة الأَفعال إِلى الفضيلة كنسبة الفضيلة إِلى السعادة.
قال: وقد تكون مواضع ما عامة للمديح وللمشورة جميعا، وإِنما تنقلب لأَحد
النوعين بتغيير يسير يستعمل فيها، وذلك أَن التي ينبغي أَن تفعل هي التي
يمدح بها إِذا فعلت. فمن عرف التي ينبغي أَن تفعل فقد عرف التي ينبغي أَن
يمدح بها. وإِذا كان ذلك كذلك، كانت له قدرة على الفعلين جميعا، أَعني
المدح والإِشارة. وذلك أَن الشيءَ الذي يأتي به على طريق الإِشارة والحث
إِذا غيره تغييرا يسيرا وبدله صار مدحا. مثال ذلك أَن يقول قائل: إِنه لا
ينبغي أَن يُتوهم أَن الأُمور العظام الشريفة هي الأُمور التي ينالها
المرءُ بسعادة الجَد وجودة الاتفاق، بل الأُمور العظيمة هي التي تنال
بالسعي وحسن الرأي. فإِنه إِذا قيل هكذا، كان كلاما مشوريا، فإِذا غير هذا
وقيل: إِن فلانا إِنما نال الأُمور العظام بسعيه وجِده لا بجَده، كان
مدحا. فالشيء الذي به يشار في هذه الأَشياء، به يكون المدح. وقد يكون
الكلام مركبا من مدح ومشورة، وذلك إِذا انتقل الخطيب من أَحدهما إِلى
الآخر، مثل أَن يقول: أَنت إِنما نلت العظائم بسعيك وجِدك، فلا تركن إِلى
ما نلت منها باتفاق وجودة بخت.
قال: وينبغي أَن يكون الاقتصاص خفيفا غير مطول، بل يكون بحيث
يؤذن دفعة بالأَمر الذي قصد أَن يؤذن به ويدل عليه، وذلك إِما بإِغلاط من
القول وإِما بلين وإِما بوسط بين ذلك، بحسب ما يليق بمقام مقام. وكذلك
ينبغي أَلا يجعل صدر الكلام طويلا، ولا يذكر فيه التصديقات فإِنه إِن فعل
ذلك لم يكن الكلام حسنا وكذلك يجب أَلا يكون أَيضا وجيزا قصيرا، ولكن يكون
قصدا معتدلا. وذلك بأَن يذكر فيه الأَمر الذي جعل إِنباء عنه من ضرر أَو
ظلم أَو غير ذلك مما يكون فيه القول، ثم يتوخى بعد ذلك أَن يكون الكلام
على مثل تلك الأُمور التي فيها الكلام وبمقدارها لا مخالفا لها ولا أَعظم
منها أَو أَصغر.
قال: ومن النافع أَن يخلط المتكلم بالاقتصاص بعض الأَقاويل التي تدل على
فضيلته ليكون كلامهُ أَقنع وأَن يستعمل من ذلك ما كان لذيذا وقوعه عند
الحكام.
قال: فأَما المجيب فينبغي أَن يقلل الاقتصاص إِن كانت الخصومة في أَنه لم
يكن الأَمر الذي أَدعى المتكلم وقوعه، أَو في أَنه لم يكن ضارا، أَو في
أَنه لم يكن ظلما، أَو في أَنه لم يكن على الصفة التي ذكر. وذلك أَن
المجيب لا ينبغي أَن ينازع خصمه فيما أَقر به، إِن لم تكن له فيه منفعة.
وذلك مثل أَن يقر أَنه فعل، ولكن لم يكن ذلك الفعل ظلما. وإِنما ينبغي
للمجيب أَن لا ينكر الأَفعال التي إِذا لم يفعل، لم يجب العقاب أَو الغرم،
أَو وجب الصفح.
قال: وينبغي أَن يكون الاقتصاص أَهليا أَي مألوفا معروفا غير منكر، وذلك
يكون بأَن يخلط به المتكلم الأَقاويل التي تحرك المرء إِلى الخلق الفاضل
وتحرض على فعل الخير، وهي الأَقاويل الخلقية. وإِنما تستعمل الأَقاويل
الخلقية في الأَشياءِ الإِرادية العملية، لا في الأَشياءِ النظرية. فإِن
الأَخلاق هي مبادئ الأعمال التي هي نحو غاية ما، لا مبادئ الاعتقادات.
قال: ولذلك لم تستعمل الأَقاويل الخلقية في الأَشياءِ التعاليمية إِلا ما
كان يَستعملُ من ذلك أَصحابُ سقراط. والأَقاويل الخلقية هي التي تؤلَّف من
لازمات الخلق، أَعني التي إِذا وجدت وجد ذلك الخلق. ولذلك قد يستعمل الخصم
أَمثال هذه دلالة على خلق خصمه، كمثل ما يقول: إِنه عجول وغير متثبت،
والدليل على ذلك أَنه يتكلم وهو يمشي، فإِن هذا يدل على الطيش وقلة
الرزانة، وهو بخلاف قول القائل: أَما فلان فإِنه يتكلم عن رويَّة واختيار
لأَنه إِنما يختار أَبداً الذي هو أَفضل إِما عند الرجل العاقل، وإِما عند
الرجل الصالح؛ وذلك أَن العاقل يختار النافع، والصالح يختار الجميل.
قال: وإِذا لم يقع التصديق بالشيء فينبغي أَن يؤتى بالسبب النوجب لذلك
الشيء، مثل ما قال فلان في فلانة، فإِنه قال أَنها كانت تحب أَخاها أَكثر
من حبها زوجَها وبنيها، لأَن هؤلاء يستعادون إِن فقدوا، والأَخ لا يستعاد
إِن فقد.
قال: ويجب إِن كان المتكلم استعمل الأَخذ بالوجوه وأَتى بالتصديق من التي
من خارج أَن يُوبَّخ ويقال له: هذا من فعل من لا يفقه الكلام، ومن فعل من
هو أَبهم بهيمة بالطبع.
قال: وينبغي أَن يخلط المقتص باقتصاصه بعض الأَقاويل الانفعالية التي هي
لازمة ومشاكلة، وهي التي تؤلف من الأُمور الموجودة فيهم أَو فيمن يتصل
بهم. وذلك أَن هذه الأُمور هي عندهم معروفة مألوفة، يعني أَن هذه الأُمور
هي التي توجب المحبة والرحمة لمن وجدت فيه، كما قيل: إِن هذا هو العقل
نفسه، ومعنى زائد على العقل وكما قال فلان في فلانة: إِنها إِلى حيث ما
رفعت يديها بلغت، يريد، فيما أَحسب، من إِمكان الأَشياءِ لها وتيسرها
عليها.
قال: وهذا يوجد كثيرا في شعر أُوميروش، كقوله في فلانة: إِن تلك العجوز
حبست عندها الوجوه الحسان، يريد أَمثال هذه الأَقاويل الانفعالية التي
توجب استغراباً للشيء وعجبا به. وهو موجود كثيرا في أَشعار العرب وخطبها،
ومن أَحسن ما في هذا المعنى قول أَبي تمام:
فلو صَوّرت نفسك لم تَزدها ... على ما فيك من كرم الطباع
فإِن هذا القول انفعالي جدا. وقريب من هذا قول أَبي نواس:
وليس على الله بمستنكر ... أَن يجمع العالم في واحد
قال: وقد يكون من الأَفعال ما يوجب الانفعال، وهي الأَفعال التي
تصدر من أُناس هم بأَحوال توجب العطف عليهم مثل الذين يتكففون الدمع
بأَيديهم من أَعينهم. فإِنهم إِذا أُبصروا بهذه الحال، أَشفق لهم وتعطف
عليهم. ولذلك صار الخصم إِذا كان بهذه الحال يضلل الحاكم. وقد يدل على
انتفاع الخصم بهذا الانفعال أَن هذه الحال قد تنفعه مع الجرم الذي هو به
مقر فضلا مع ما هو له منكر.
قال: وكثيرا ما يحتاج المتكلم أَن يتكلف عمل الاقتصاص في بدء كلامه، وربما
لم يحتج إِلى ذلك.
فأَما الكلام المشاوري فليس فيه اقتصاص أَلبتة، لأَنه ليس يكون اقتصاص
فيما سيكون، وإِنما الاقتصاص فيما كان أَو هو كائن الآن. وإِنما تذكر
الأُمور المتقدمة في المشورة على جهة البرهان، أَعني أَن يبين بها وجود
الأُمور المستقبلة. ولذلك كلما كان المشير أَعرف بالأُمور السالفة
الواقعة، كان أَحرى بحسن المشورة فيما هو كائن بأخَرة. فأَما المدح والذم
فالأَمر فيه بخلاف هذا، أَعني أَنه تذكر فيه الأَشياء السالفة والحاضرة
على جهة الاقتصاص. وليس في المشورة اقتصاص إِلا أَن يكون الخطيب ينتقل من
المدح إِلى المشورة. ولكن إِذا كان الأَمر الذي يَعِدُ به مما لا يصدق
بوقوعه، فينبغي له أَن يأتي بالعلة في الشيءِ الذي يَعِدُ بوقوعه، ثم بعد
ذلك يتكلم في موجبات ذلك الواقع قال: وأَما التصديقات فينبغي أَن تكون
أَقاويل تثبيتية. فإِن التثبيت أَمر خاص بالتصديقات في جميع أَنواع القول
الخطبي. والأَشياء التي تكون فيها المنازعة في الخصومة، وهي التي يجب أَن
يوقع بها التصديق، هي أَنحاء: أَحدها أَن الشيءَ كائن، وذلك إِذا مارى
الخصم في كونه، أَعني أَن يجحده. ولذلك ما يجب على الشاكي أَن يأتي على
كون ذلك الشيء بالبرهان، أَعني بالمثال. والنحو الثاني: هو في أَن الشيءَ
ضار أَو ليس بضار، وذلك إِذا اعترف الخصم بأَنه قد كان ونازع في أَنه ضار.
والثالث: أَنه عدل أَو ليس بعدل، وذلك إِذا اعترف بأَنه واقع وضار ونازع
في كونه جوراً. والرابع: أَن يعترف الخصم أَنه ضار وغير عدل ولكن يدعي أَن
خصمه كان السبب فيه بما تقدم من جوره عليه، مثل مَنْ يقر أَنه أَغضب
إِنسانا، لكنه يزعم أَنه إِنما فعل ذلك لغضب متقدم كان منه، ففعل ذلك
لينتصف منه. وهذا كأَنه راجع إِلى دعوى العدل. وإِذا اعترف الخصم بأَنه
ضرر، ولكن خصمه كان السبب فيه، فبين أَن الخصومة حينئذ إِنما تكون في أَن
خصمه كان السبب أَو لم يكن. وقد تكون الخصومة في هل يطلق لمن جير عليه أَن
يجر بقدر ما جير عليه دون أَن يرفع ذلك إِلى الحاكم، كما يوجد الاختلاف في
ذلك عند الفقهاء في ملتنا.
قال: والخصومة في مثل هذا هي نافعة للشاكي، ضارة للمجيب، أَعني إِذا اعترف
المجيب أَنه جار وادعى أَن السبب فيه خصمه. وأَما في تلك الأخر، وبخاصة في
أَن الأَمر لم يكن، فهي للمجيب أَنفع منها للشاكي.
قال: وأَما المنافرية فقد ينتفع فيها كثيرا باستعمال الشبيه والقول
المثالي، أَعني في تبيين وجود تلك الأَفعال. وأَما في تلك الأَفعال جميلة
أَو نافعة، فإِن الاستدلال على ذلك يكون من الأُمور أَنفسها، وقد يستدل في
الأَقل على ذلك بالتمثيل، وهو الذي يعرفه أَرسطو بالبرهان في هذه الصناعة،
وإِنما يحتاج في الأَكثر إِلى استعمال المثال إِذا كانت الأُمور غير مصدق
بوجودها أَو كان هنالك علة تمنع التصديق بوجودها.
قال: وأَما القول المشاجري فالذي يستعمل فيه التثبيت إِنما يبين إِما أَن
الأَمر لا يكون، وإِما أَنه سيكون، وإِما أَنه إِن كان، فليس عدلا أَو ليس
مما ينتفع به، أَو ليس على هذه الصفة ينبغي أَن يكون.
قال: وقد ينبغي أَن يتفقد كذب المتكلم في المشوريات واستعماله الأُمور
التي هي خارجة عن الأَمر أَكثر منها في سائر الأَنواع.
قال: والعلامات وإِن كانت كاذبة بالجزء، كما قيل، فقد يستعملها
هذا الجزءُ من الخطابة كما تستعملها سائر الأَجزاءِ. والمثالات أَخص
بالمشاورة وأَولى بها. وأَما الضمائر فهي أَخص بالخصومة، لأَن الإِشارة
إِنما تكون بما هو آت. ولذلك يجب أَن يؤتى بالبرهان عليه مما قد كان، وهو
المثال. وأَما الخصومة فإِنما تكون في أَن الشيءَ موجود أَو غير موجود،
ولذلك يكون المثبت فيها من الأَشياءِ الضرورية التي تلزم ذلك الشيءَ، لأَن
الذي قد كان، لازمه ضروري الوجود، أَي موجود بالفعل، لا ممكن الوجود.
وأًَما الأُمور المستقبلة فلازمها مستقبل الوجود، فلذلك كانت المثالات
أَخص بها من الضمائر.
قال: وليس ينبغي أَن يؤتى بمقدمات الضمائر على النسق الصناعي، بل ينبغي
أَن يخلط بعضها ببعض، وإِلا أَضر بعضها بعضا. فأَما أَن يؤتى بها على
الترتيب الصناعي وهو الترتيب الذي يظن أَنه قياسي، أَعني أَكثر من غيره،
فليس ينبغي أَن يفعل ذلك في جميع الضمائر كما كان يفعله أُناس من
المتفلسفين.
قال: وإِذا أَردت أَن تعمل قولا انفعاليا، فلا تعملن منه ضميراً تصديقياً.
فإِنك إِن فعلت ذلك، إِما أَن ترفع الانفعال الذي قصدت فعله، وإِما أَن
يكون الضمير باطلا، لأَنك تصدم بعضها ببعض. وإِذا اجتمعا معا، فإِما أَن
يفسد أَحدهما الآخر، وإِما أَن يوهنه.
وكذلك أَيضا إِذا أَثبت بالكلام الخلقي، فلا ينبغي أَن يأتي بالضمير
والتثبيت معه، لأَنه ليس التثبيت مما يفعل في السامع اختيار الشيء كما
تفعله الأَقاويل الخلقية.
ولكن ينبغي أَن يستعمل: أَما في الأَقاويل الخلقية فالأَقاويل الرأْيية،
وأَما عند الاقتصاص فالأَقاويل التصديقية. فمثال الأَقاويل الخلقية قول
القائل: إِنك عارف بهؤلاءِ فلا ينبغي أَن تصدقهم. ومثال الانفعالية قول
القائل: إِن هؤلاء مظلومون فلا ينبغي أَن تضجر بهم. وأَما التصديقات
فإِنما تكون في أَن هذا عدل أَو نافع.
قال: والإِشارة في الأَكثر أَصعبُ من الخصومة، من أَجل أَن المشورة تكون
في المستقبل والخصومة في الماضي. وما كان في الماضي أَعرف مما يكون في
المستقبل، ولذلك كان التكهن في الماضي أَسهل منه في المستقبل، كما قال
فلان في فلان أَنه كان يتكهن في الماضي ولم يكن يتكهن في المستقبل، يريد
فيما أَحسب الغض منه.
قال: والقول المثالي هو من الأُمور الظاهرة الحكم جدا ويسهل به وجدان
البرهان على الشيءِ من قبله والتصديق به، وليس فيه محاورة كثيرة خارجة عن
الشيءِ، كالذي يكون نحو الخصم من تخسيسه، أَو نحو نفسه من تفضيله، أَو في
تصيير الحاكم إِلى الانفعال. اللهم إِلا أَن يروغ المتكلم به أَو يحيد عن
الطريق، يريد لأَن هذه العلة كان أَخص بالمشورة.
قال: وينبغي للمتشكك في المقدمات المأخوذة من السنة أَن يفعل فيها ما كان
يفعله سقراط مع الخطباء من أَهل أَثينية، فإِنه كان يذم لهم تلك المقدمات
ذما يسيراً، يريد، فيما أَحسب، بالتأويل لها. فإِن التأويل ذم ما للقول.
قال: وأَما المنافريات فقد ينبغي أَن يستعمل فيها مدح الكلام التثبيتي،
مثل ما كان يفعله سقراط في أَقاويله المدحية. فإِنه كان يدخل في أَثنائها
مدح الكلام. وذلك مثل قول القائل: إِنه مَن مدَح فلانا فليس يعوزه مقال
ولا تبقى له مقال. وإِذا كان هذا في مدح الإِنسان، فكيف في مدح الإِله.
والكلام التثبيتي إِذا استعمل فيه المدح كان تثبيتا وخلقيا معا، وإِن لم
يكن هنالك قول خلقي، وذلك مثل قول القائل: بعد أَن يأتي بالتثبيت: إِن
الكلام المحقق الصحيح لا يعقله إِلا ذوو الفضل والصلاح.
قال: والموبخات فهي أَنجح من المثبتات، يعني بالموبخات، التي تكون على
طريق الخلف من المقدمات التي يعترف بها الخصم، وبالمثبتات الضمائر التي
يأتي بها المتكلم في إِبطال قول الخصم من تلقائه.
قال: وإِنما كانت الموبخات أَنجح من الضمائر لأَنه معلوم أَن الموبخات
تفضل غيرها من الأَقوال في الشيء الذي به الأَقوال قياسية، أَعني أَنها
قياسية أَكثر من غيرها، إِلا أَنها إِنما تأتلف من المقدمات المتضادة.
والمتضادة إِذا قرن بعضها ببعض كان أَحرى أَن يظهر الكذب الذي فيها.
قال: والكلام الذي يوجهه نحو الخصوم ليس يكون من نوع آخر سوى نوع
الأَقاويل التصديقية فمنها ما تكون المقاومة فيه بحسب قول الخصم، وهي
المقاييس التي تأْتلف من المقدمات المتقابلة أَو التي قوتها قوة
المتقابلة، وتسوق إِلى التوبيخ. ومنها ما تكون من الأَمر نفسه، وهي
المقاييس المستقيمة.
قال: وقد ينبغي في المشورة والخصومة معا إِذا ابتدأَ المتكلم بالكلام أَن
يذكر أَولاً التصديقات التي تثبت قوله ثم يقصد بعد ذلك لإِبطال المخالفات
لقوله. هذا إِذا كانت المخالفات له يسيرة أَو قليلة الإِقناع، وأَما إِن
كانت كثيرة أَو قوية الإِقناع، فإِن العمل كله هو في أَن يتقدم فينقض تلك
الأَقاويل. فإِذا أَوهم بطلانها، أَتى بعد ذلك بالتثبيتات التي تخص قوله،
وبالجملة: فينبغي للمتكلم الذي يريد أَن يتكلم بضد كلام قد تكلم به غيره
أَن يوطئ لنفسه ويطرق لكلامه، ولا سيما إِذا كان الكلام الذي تكلم به
الغير كلاما منجحا، أَي مقنعا. وذلك يكون بوجوه، مثل أَن يقول الخصم: إِنك
معنى بالكلام ذو قدرة عليه. وإِنك تثبت كل ما تريد أَن تثبته، وتقنع في كل
شيء أَنه واجب وأَنه عظيم وأَنه نافع ليعتقد في قولك أَنه صحيح ومحقق،
وإِن لم يكن صحيحا عند الله ولا عند الحق نفسه. وربما استعمل في هذا ذم
الكلام وذم المتكلم، مثل أَن يقول له: إِن كلامك محك وباطل وكلام رجل لا
تورع عنده. وكأَن هذا الموضع الذي ذكره هو راجع إِلى ذم كلام الخصم إِما
من جهة الباطن وإِما من جهة الظاهر. وذم الخصم نفسه أَو كلامه هو مقابل
مدح المتكلم نفسه وكلامه. وإِنما تذكر هذه الأَشياء هاهنا من جهة الترتيب؛
وإِلا فقد تقدم الكلام فيها.
قال: وقد ينبغي أَن تغير الضمائر إِلى الأَقاويل الخلقية أَحيانا مثل أَن
يقول الخطيب إِذا أَشار بالصلح والهدنة: لأَنه ينبغي للعقلاءِ أَن يصيروا
إِلى الصلح والهدنة. وبالجملة فيجب على الخطيب أَن يتكلف من الضمائر أَقوى
ما يمكن أَن يوجد في ذلك الشيء الذي يتكلم فيه. فإِنه مهما كانت الضمائر
التي يأتي بها الخطيب أَنجح فهو أَحرى أَن يقبل قوله وأَن يظهر على خصومه،
مثل أَن تكون الضمائر التي يأتي بها في قبول الصلح أَقوى من الضمائر التي
يأتي بها خصمه في دفع الصلح والإِشارة بالحرب.
قال: فأَما السؤال فإِنما ينبغي أَن يستعمل في هذه الصناعة أَكثر من ذلك
في مواضع: أَحدها: إِذا علم السائل أَن المجيب متى أَجاب بنعم أَو لا لزمه
شيء واحد بعينه وهو الذي قصد المتكلم إِلزامه، مثل أَن يُسأَل أَلست قد
أُخِذْتَ بقرب القتيل وبيدك سيف؟ فإِن قال: نعم، قيل: أَنت قتلته؛ وإِن
قال: لا، قيل: فأَنت قتلته، فلذلك فررت.
والموضع الثاني: حيث يعلم إِنه إِن لم يجب بالشيء الذي سأَله فقد قال
شنيعا، مثل قول القائل: أَلست تعلم أَن الإِتاوة جور. فإِنه إِن قال: لا،
كان شنيعا؛ وإِن قال: نعم، قيل له: وأَنت تأخذ الإِتاوة، فأَنت جائر
والموضع الثالث أَن تكون المقدمة التي يسأَله عنها ظاهرة الصدق، ولا يكون
ما يلزم عنها ظاهرا عند المجيب. فإِنه في مثل هذا الموضع يجب على السائل
أَن يقتصر على مقدمة واحدة فقط، ولا يسأَل عن المقدمة الثانية. مثل أَن
يَسأَل سائل رجلا من النصارى: أَليس الآباء و الأَبناء من جنسٍ واحد؟
فإِذا قال المجيب: نعم، قال: فعيسى إِذن ليس ابنا لله. فإِن هذه المقدمة
يمكن أَن تخفي لظهورها، وبَعد لازمها، وهي خافية في الأَكثر أَعني في بادئ
الرأي، على المجيب في هذا السؤال.
والموضع الرابع: حيث يعلم السائل أَنه إِن أَجاب بضد ما سأَله قدر على
إِلزامه التشنيع. والفرق بين هذا وبين الثاني: أَن الشنيع هنالك كان ضد ما
سأَله عنه، وهنا إِنما أَلزمه السائل الشنيع بقياس.
والموضع الخامس: إِذا كان الأَمر عند السؤال يضطره أَن يجيب بالمتناقضات
معا فإِنه يلزمه التوبيخ الذي يفعله السوفسطائيون. مثل أَن يلزمه بالسؤال
أَن يكون مجيبا في الشيء بنعم وبلا. فإِنه يشغب عليه حينئذ كما يفعل
السوفسطائيون.
والموضع السادس: أَن يسأَل سؤالا يتضمن معاني كثيرة ويتشغب
الجواب فيه على المجيب. فإِنه إِن أَجاب في ذلك بالمعنى الذي قصده السائل
لزمه الأَمر. وإِن جعل يفصل تلك المعاني واحدا واحدا ويجيب فيها بجواب
جواب، رأَى السامعون من العمة لضعفهم أَنه مريد وأَنه لذلك قد اضطرب
جوابه، إِذا كانوا يرون أَن الصادق إِنما يجيب إِذا سأَل بجواب واحد لا
بأَجوبة كثيرة، لأَن ذلك اضطراب وتشويش في الجواب.
قال: وأَما المجيب فقد ينبغي له في هذه الصناعة أَن ينكر إِنتاج الضمائر،
إِذا لم يقدر على إِنكار المقدمات التي سئل عنها. وإِذا أَمكنه الإِنكار،
فلا ينكر باللفظ المحتمل الذي يكون أَعم من ذلك الشيء الذي فيه المراء ولا
أَخص. وينبغي له أَن يتقدم فيعلم المقدمات التي تفعل القياس على الشيء
الذي يروم خصمه أَن يثبته عليه. وذلك مما يسهل علمه من الأَشياءِ التي
قيلت في الثانية من طوبيقى. فإِن تلك الأَشياء إِما كلها وإِما بعضها هي
مما يصلح في هذا الموضع وينتفع بها وإِن تم القياس عليه فينبغي له أَن
يذكر أَن علة النتيجة هي غير العلة التي ذكرها الخصم، مثل أَنه إِذا أَنتج
عليه أَنه أَخذ المال فيقول: نعم أَخذته لمكان الحفظ له، لا لمكان الغصب.
قال: والسائل فقد ينبغي أَلا يَسأَل عن المقدمات البعيدة ولا عن القريبة
من النتيجة نفسها إِلا أَن تكون ظاهرة جدا، بل ينبغي أَن يسأَل عن
المقدمات التي هي من النتيجة بحال وسط في القرب والبعد.
قال: ولأَن الأَقاويل التي تستعمل الهزء والسخرية لها غناء في المنازعات،
فقد ينبغي أَن تدخل في المخاطبات التي فيها النزاع. ولذلك قال فلان: إِنه
ينبغي أَن يفسد الجِد بضده أَي الهزل، ويفسد الهزل بضده أَي بالجد. وذلك
صواب من قوله. وقد قيل في كتاب الشعر كم أَنواع الهزل. ومن أَنواع الهزل
ما يليق بالكريم، وهو الهزل الذي لا يكمن فيه صاحبه على أَمر باطن وتعريض
قبيح بل يكون ما يتكلم فيه بالهزل هو نفس الشيء الذي قصده، لا أَنه عرّض
بذلك عن أَمر قبيح. ولذلك قيل: إِن المزَّاح يواجهك بالمزاح ويبدي لك ما
في نفسه، وإِما المعرّض فهو الذي يخادعك ويوهمك أَنه يتكلم في شيء وهو
يذهب في الهزل إِلى شيء آخر قبيح. فالمزَّاح أَشبه بالكريم لأَنه يصدق عن
ذات نفسه، والمعرّض أَشبه باللئيم لأَنه يستعمل الخب والحقد.
قال: وبالجملة فالأَشياء التي منها يتقوم الكلام الخطبي ويتركب عنها هي
أَربعة أَشياء: أَحدها أَن يثبت عند السامعين من نفسه الصحة ومن خصمه
التهمة. والثاني تعظيم الشيء المتكلم فيه وتصغيره.والثالث الأَقاويل
الانفعالية والخلقية. والرابع: الأَقاويل الموجهة نحو الشيء المتكلم فيه.
وهذه الأَشياء كلها مشتركة لجميع أَجزاء الخطابة، أَعني الأَجزاء الثلاثة.
قال: ونحن فقد قلنا في المواضع التي منها تعمل هذه الأَشياء كلها.
وبالجملة فقد وفينا بجميع المعاني التي وعدنا بذكرها في أَول هذا الكتاب.
وكان ذكرنا لهذه الأَشياء أَما في أَول الأَمر فلكي يكون ما يتكلم فيه
معلوما غير مجهول، كالحال في فعل الذين يريدون أَن يحسنوا التعليم، أَعني
أَن يحضروا أَولاً الأَغراض والمعاني التي يريدون أَن يتكلموا فيها، ثم
يتكلمون فيها. وأَما ذكرنا إِياها هاهنا وبأخرة فلكي يعلم أَنا قد وفينا
بما كنا وعدنا في ذلك. وهذا هو مبلغ الخاتمة التي تخص المتكلم أَعني أَنه
يعلم بأَنه قد وفى بما ذكر. وأَما الذي يخص السامعين فهو التذكير.
قال: والمثالات فينبغي أَن تكون بالجملة بحيث يفهم منها الشيء الذي أخذ
المثال بدلا منه، ويفهم من ضدها ضده. وذلك إِنما يكون متى كان هذان
الأَمران في المثال أَعرف منهما في الشيء الذي استعمل المثال بدله، أَعني
أَن يكون أَعرف من الممثَّل، وضده أَعرف من ضد الممثَّل. فإِنه متى لم يكن
المثال هكذا، كان إِما ليس يثبت شيئا وإِما أَن يثبت به ما قد ثبت، وذلك
إِما بمثال آخر، وإِما لأَنه معروف بالطبع. وكذلك الحال في معرفة ضد
الشيء، أَعني أَن منها ما يكون معروفا بنفسه، ومنها ما يكون معروفا بمثال.
قال: وأَما خواتم الخطب فينبغي أَن تكون منفصلة عن الخطبة غير مرتبطة بها
ولا متصلة، بمنزلة الصدر ولكن تكون موجهة نحو الكلام الذي سلف، مثل قول
القائل في الخطب المشاورية: هذا قولي فاسمعوا، والحكم إِليكم فاحكموا.
وهنا انقضت معاني هذه المقالة الثالثة. وقد لخصنا منها ما تأَدى
إِلينا فهمه وغلب على ظننا أَنه مقصودة وعسى الله أَن يمن بالتفرغ التام
للفحص عن فص أَقاويله في هذه الأَشياء وبخاصة فيما لم يصل إِلينا فيه شرح
لمن يرتضى من المفسرين.
وكان الفراغ من تلخيص بقية هذه المقالة يوم الجمعة الخامس من محرم عام
أَحد وسبعين وخمس مائة.