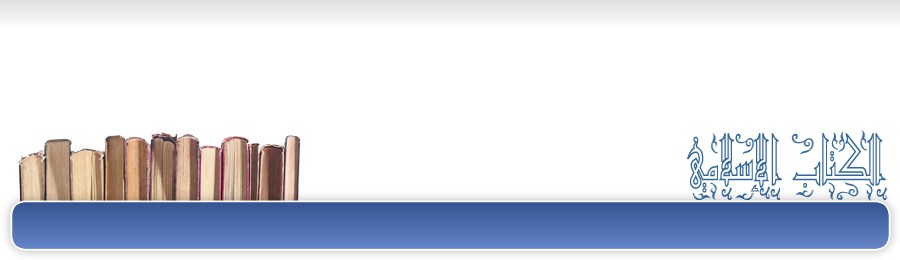كتاب : فقه تغيير المنكر
المؤلف : د. محمود توفيق محمد سعد
التغيير ضرورة وغاية
بيان السنة ضرورة التغييرإن منهج الإسلام في بناء المسلم عقيدةً وسلوكا لا يرمي إلى أن يجعله صالحاً في نفسه فحسب ، بل يتجاوز ذلك إلى أن يجعله الصالح المصلح ، فيه يتحقق الوجود المتمكن للأمة المسلمة ، وبه ترتقي الأمة من طور الاتصاف ( بالإسلامية ) انتساباً إلى أفق ( المسلمة ) سلوكا ووجودا .
المسلم الصالح في نفسه فحسب ، به تكون الأمةُ الإسلامية ، ولا تقوم به الأمة المسلمة ، فإنَّ المسلمة أمة صالحة في نفسها مصلحة ما حولها . ومن ثمَّ كانت دعوة الإٍسلام رامية دائماً إلى الصلاح والإصلاح معاً ، ولن يكون إصلاح البتة إلا بتحقق الصلاح الذاتي وتمكنه .
يقول الله تعالى : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } ( التوبة : 71 ) .
{ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا } ( طه : 132 ) .
{ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ
لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ }{ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ } ( الحج :40ـ
41 ) .
{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
} ( التحريم : 6 )
في تلك الآيات وغيرها يمتزج الصالح بالمصلح ليشكل كنه المسلم الذي به تقوم
الأمة المسلمة ، التي لا تستقيم حركة الحياة بغير قيادتها وريادتها .
وفي السنة أحاديث كثيرة ، يمتزج فيها الصلاح بالإصلاح :
عن درة بنت أبي لهب ، قالت : « قام رجُلٌ إلى النبيَّ ـ صلى الله
عليه وسلم ـ وهو على المنبر فقال : يا رسول الله ! أيَّ الإسلام خير ؟
فقال صلى الله عليه وسلم : خير الناس أقرؤهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف
وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم » . امتزج الصلاح الذَّاتي ( أقرؤهم
وأتقاهم ) بالإصلاح الجمعي ( آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر ، وأوصلهم
للرحم ) ، فليس ( الإقراء ) حسن التلاوة والحفظ فحسب ، بل هو إلى ذلك أيضا
: حسن فقه ما يقرأ ، وحسن تطبيقه وطاعة ما به أمر وعنه نهي .
فالأمة المسلمة لا يكون المرء فيها صالحاً في نفسه ، منصرفا عن غيره،
مشتغلا بحاله ، بل هو صالح في نفسه ، ومصلح لما حوله ثانيا : إنسانا وكونا
.
والحق عز وجل جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس بصلاحها وإصلاحها معاً :
{ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ }
( آل عمران : 110 ) .
فهي أمة أخرجت للناس ، أي لما فيه صالحهم ، وقد جعل قوله : {
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ } ... إلخ شرط هذه الخيرية، وبيان كونها أخرجت
للناس ولمصلحتهم . وقد فقه الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ذلك فقها بالغاً ،
فتحققت بهم فقها وسلوكاً الأمة المسلمة ، كما يحبها الله تعالى : عن عمر
بن الخطاب رضي الله عنه ـ قال : لو شاء الله لقال ( أنتم خير أمة ) فكنا
كلنا ولكن قال (كنتم) فهي خاصة لأصحاب محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن
صنع صنيعهم ، قوله ( من صنع صنيعهم ) : بيان أن من تحقق فيه كما تحقق في
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاح والإصلاح في القرون التالية إلى
يوم القيامة ، فهو منهم .
وقد فسرها أبو هريرة أيضا تفسيرا كاشفا عن حقيقة هذه السِّمة الرافعة
للأمة من طور ( الإسلامية ) ، إلى أفق ( المسلمة ) :
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ
أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ } قال : خير الناس للناس : تأتون بهم في السلاسل في
أعناقهم ، حتى يدخلوا في الإسلام.
ليس في هذا دعوة إلى إكراه الناس على الإسلام ، وقسرهم عليه ،
فإن سيدنا أبا هريرة أفقه وأحكم من أن يفسرها تفسيراً يصطدم مع قول الله
تعالى :
{ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ } (
البقرة : 256) .
ولكنه فسرها تفسير أهل الحكمة والبلاغة العالية : إنه يريد ، إنكم تكونون
خير الناس للناس ، إذا ما دعوتموهم إلى الإسلام بالحكمة والقدوة والأسوة
والسلوك الملتزم هدي الله تعالى في كل حال ، وبالحلم والأناة والصبر
والمصابرة فتأسرونهم وتأخذون بمجامع قلوبهم وعقولهم فقهاً وسلوكاً ،
فينقادون لكم وللدخول في الإسلام إعجاباً واقتناعاً ، كانقياد الأسير
المغلول في السلاسل ، فهو أسر دعوة وقدوة وأسوة ، لا أسر أغلال وأصفاد ،
فسيدنا أبو هريرة عليم بأن قسر امرئ على عقيدة ما ، لا يكون خيراً له ،
ولو أنه أراد ظاهر عبارته لكان صدرها متناقضاً مع عجزها ، كما لا يخفى ،
وأبو هريرة ، أحكم من أن يختلط عليه ما يقول .
ففي الآية بيان حقيقة الأمة المسلمة ، وقوامها : فعل الخير والدعوة إليه والإعانة عليه ، وترك الشرِّ والنهي عنه ، حتى تستقيم حركة الحياة ، فإن بذلك بقاء الحياة وصلاحها ، ولذلك جعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الحياة في هذه الأرض كمثل الحياة في سفينة تمخر عباب البحر ، لا نجاة لها ، ولمن فيها ، إلا بالدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والأخذ على أيدي المفسدين .
بيان السنة ضرورة التغيير
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها ، إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ، ولم نؤذِ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادُوا هلكُوا جميعا ، وإن يأخذوا على أيديهم ، نجوا ونجوا جميعا » .الصورة التي يقدمها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لواقع الحياة على هذه الأرض ، وعلائق الناس فيها ، ببعضهم ، ومسؤوليتهم في الحفاظ على بقائها وصلاحها صورة منتزعة من واقع مشاهد ، لا يتأتى لأحد أن يجادل ، أو يتوقف فيه البتة ، فلن يكون منه إلا التسليم بما ينتهي إليه التصوير والمقارنة والموازنة ، من هدي يأخذ بأيدي الناس إلى التي هي أهدى وأقوم ، اقتناعا واطمئنانا ، فينقادون إليه انقياد ذي الأغلال ، إلى خير ، يرمى به إليه .
يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم ، القائم على حدود الله تعالى ، المراقب لها ، الواقف عند حماها في جميع شأنه ، والواقع فيها ، الراتع المنهمك المستمر في انتهاكها ، فلا يرعوى ، يشبه هذين الصنفين ـ وفي رواية لأحمد يضيف إليهم المداهن في حدود الله . المصانع المنافق ، المزين لانتهاك الحرمات ، الساكت عن ذلك . الانتهاك ، تحت ستار الحرية ـ يشبه هذه الأصناف الثلاثة وعلائقهم ببعضهم على ظهر هذه الأرض ، بقوم شاءوا السفر في سفينة تمخر عباب البحر ، فكان بينهم استهام المنازل واقتسامها ، فكان لبعضهم أعلاها ، وكان لبعضهم أسفلها ، وهو أوعرها وشرها كما في رواية لأحمد ـ وكذلك منازل الناس في الحياة على هذه الأرض ـ وكان الذين في أسفلها في حاجة إلى أن يستقوا ماءً ، فإذا استقوا مرّوا على من فوقهم ، النازلين اقتراعاً أعلى السفينة ، فكان ضرورة أن يَصُبّّ الأسفلون عند مرورهم على الأعلين ، فتأذى الأعلون ، وفي رواية للترمذي وأحمد « فقال الذين في أعلاها : لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا » فثقل ذلك على الأسفلين : كما في رواية لأحمد « فقال الأسفلون : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نمرَّ على أصحابنا فنؤذيهم » ،
وفي رواية للبخاري : « فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه
فقالوا : ما لك ؟ فقال : تأذيتم بي ولابد لي من الماء » وهنا برز صنيع
المداهنين المصانعين ، الذين يبغون الفتنة في الأرض ، تحت شعار الحرية
الشخصية ، فقال بعضهم كما في رواية للإمام أحمد : « إنما يخرق في نصيبه »
، وقال الآخرون : لا ، فإن أخذوا على يدي ذلك الخارق ، ولم ينخدعوا بمقاله
المداهن، الرافع شعار (( الحرية الشخصية )) نجا الجميع ، وإِن تركوه يخرق
في نصيبه خرقاً هلكوا جميعاً.
هذا التفصيل لوقائع الأحداث في المشبه به ( أصحاب السفينة ) يشير إلى
وقائع مثلها في حياة الناس ، في هذه الأرض .
والرسول صلى الله عليه وسلم ـ اختار موقع أحداث المشبه به سفينة ، وهو
مكان دال على عظيم تعرضه للمخاطر الجسام ، التي لا تخفى ، ليهدي الناس إلى
أنَّ هذه الأرض ، وما عليها ، لا تقل تعرضاَ للمخاطر الجسام عما تتعرض له
السفينة في بحر لجيَّ ، قد تكون خطايا بعض ساكنيها سببا لهلاك جميعهم حين
لا يأخذون على أيديهم .
قال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }{ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (الأنفال : 24 ـ 25 ) .
هذه الصورة الكلية التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم ، ببيانه الحكيم تجمع بين واقعين متشابهين متماثلين : واقع ممتد عبر الحياة زماناً ومكانا ، هو واقع القائمين على حدود الله ، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، وواقع الواقعين فيها ، التاركين للمعروف ، المرتكبين للمنكر ، وواقع المداهنين المصانعين في الحق ، الساكتين على الشر ، يقابل ذلك الواقع واقع قريب إلى الأذهان والأبصار لا يكاد يغفل عنه ، أو يجهله أحد من الناس ، هو صورة المشبه به : صورة تجعل المتلقي كأنه يرى الأحداث تجري أمام عينيه : يرى سفينة في بحر لجيّ ، يقبل قوم على الإبحار فيها ، ويرى تقاسم القوم ، واستهامهم مواقع فيها ، فإذا قوم في أعلاها ، وقوم في أسفلها . هكذا تبدأ الأحداث ، دون أن يكون فيها ما يخرجها عن سنن العدالة ، وكذلك تبدو الحياة على الأرض ، ثم تأتي ضرورات الحياة وحاجاتها ، وأثرها في مجرياتها ، وعلائق الناس بعضهم ببعض وفقا لمناهجهم في التعامل مع تلك الضرورات والحاجات ومن تكون عندهم ، فالأعلون ممتعون بالاستقاء دونما حاجة إلى مرور على غيرهم ، فتتحقق ضروراتهم وحاجاتهم دونما اصطدام بالآخرين وكذلك طائفة من الناس في هذه
الحياة .
والأسفلون يقتضي تحقيقهم ضرورات حياتهم ومصالحهم المرور على غيرهم
والاصطدام بهم ، فإذا هم أمام أمرين عظيمين :
· ضرورة تحقيق ضروراتهم وحاجاتهم .
· ضرورة الاتصال بالآخرين والاحتكاك ببعض شؤونهم .
وتلك حال الجمهرة الكاثرة من الناس في هذه الحياة ، وهنا تكون الحكمة
والحنكة ، وتقدير الأمور بمقاديرها ، وفقاً لما يقضي به حسن البصيرة
والفراسة ، واستبصار العواقب من الأسفلين ، ومن شاكلهم ، وهنا يكون
الإيثار والصبر الجميل ، والاحتساب والفضل من الأعلين ، ومن شاكلهم .
الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هديه هذا يرسم لنا صورة لما هو الغالب
على الطائفتين في الحياة : الأعلين والأسفلين ، فلا أيثار ولا احتساب ولا
فضل من الأعلين ، ولا حكمة ولا حسن بصيرة من الأسفلين . فيصور لنا الأعلين
، وقد تأذوا من مرور الأسفلين عليهم ، والمرور حقهم وضرورة من ضروراتهم ،
فكان هذا من الأعلين غير حميد .
إِنَّ اقتسام الأشياء عدالة وارتضاء ، لا ينفي أن يكون للآخرين
بها بعض الحق ولو من وجه خفي ، فليس الذي يملكه هذا ، بِخال من حق الآخرين
فيه ، فكل أمر الإنسان وشأنه وماله من الموجودات حساً ، ومعنى ، لغيره فيه
بعض الحق : جسده وعقله وقلبه ، ماله وولده وعلمه ، تقواه وقدره وجاهه ...
إلخ .
وما يكون لأحد ، ولا ينبغي له أن يتبرم من أن يستعمل الآخرون ما لهم من حق
، فيما ملكت يده بفضل الله تعالى . وغير قليل من الناس تضيق نفوسهم حين
يطلب الآخرون حقوقهم عندهم ، فترتسم آيات الضجر على الوجوه ، وقد تلفظ
الأفواه كلماتٍ طاعنات ، وقد تمتد الأيدي ، بما يؤذي الطالبين حقاً لهم ،
وما ذلك بالمنهج الأمثل في الإسلام .
الأمثل إسلاماً ، إظهار البشاشة والرضا ، حين يطلب الآخرون حقوقهم ، بل من
حقهم على من تكون حقوقهم في أيديهم ، أن يبثوا في نفوسهم رضاهم باستخدام
حقهم المتعلق بما ملكت أيديهم ، ويوحون إليهم ، أن أخذه منهم أحبُّ إليهم
، أو كمثل حبهم هم ، أن يأخذوا ما لهم عند غيرهم ، فقد هدى النبي صلى الله
عليه وسلم إلى ذلك بقوله : « لا يؤمن أحدكم حتى يُحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه
» .
وفيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حال الأعلين ، تصوير لما
يكون من بعض الأمة من دافعات إلى الخطايا ، وإن كثيراً مما يقترفه
الجاهلون ، يحمل جمع من غيرهم أوزار حملهم عليه واضطرارهم للتردي فيه ،
بما يكون منهم ، من أساليب حاملة على ذلك . منها ما هو مقصود ، ومنها ما
هو عن غفلة وجهالة.
من مسؤولية الأعلين ومن ضارعهم في الأمة ، أن يعتصموا من حمل غيرهم على
التردي في الخطايا .
الغني حين يمتنع عن أداء زكاة ماله ، أو يتأخر في إخارجها ، يحمل بعض
الفقراء على التردي في بعض الخطايا : سرقة ، أو استجداءً أو احتيالاً ،
فتُخرَقُ السفينة .
الزوج حين يحرم زوجه من بعض حقوقها الحسية والمعنوية ، يحملها على أن تسقط
في مستنقع النشوز أو الخيانة ، فتُخرقُ السفينة .
الأب حين يحرم بنيه بعض حقوقهم ، يحملهم ، على التردي في هاوية العقوق ،
فتُخرقُ السفينة .
المعلم حين يحرم تلاميذه بعض حقوقهم ، فلا يحسن إعداد نفسه علماً وصنعة ،
ولا يخلص في تعليمهم ، يحمل بعضهم على أن يختلس العلم ، أو يسرقه عند
اختباره ، فتُخَرقُ السفينة.
ولي الأمر الأعلى حيث يحرم شعبه حقه عليه ، في أن يحكمهم بما شرع
خالقهم ، لا بما شرعه هو ، وبطانته ، يحملُ شعبه أو بعضه على أن يخرق
السفينة خرقاً لا يكاد يصلح : يسقط حبه وهيبته والثقة فيه من نفوسهم ،
وتمتلئ القلوب والعقول كرهاً وادعاء خيانة ، فيسهل على الدهماء الخروج
عليه ، فيفسدون في الأرض ، فتُخرَقُ السفينة . والمسؤول عن ذلك هو ولي
الأمر وبطانته ، إذ منع شعبه حقه .. وإذا ما كان الدال على الخير كفاعله
فإن الحامل لغيره على الشر كفاعله .. وما خرجت أمة قط على إمام عدل ،
فالعدل أساس الملك ، ولا يكون عدل البتة إذا لم يك وفقاً لما أنزل الله عز
وجل .
إن الحكمة لتقتضي بأن ليس الصلاح أن لا تفعل الشر ، بل وألا تحمل الآخرين
عليه ، بل وأن تعينهم على الاعتصام من التردي في خباله .
والرسول صلى الله عليه وسلم يصور لنا حال الأسفلين في السفينة بين شقي
الرحى : حاجتهم إلى الماء ، وهو ضرورة الضرورات ، وتأذي الآخرين من المرور
عليهم .
فإذا بالبصائر تغشى فلا تقدر الأمور قدرها ، ولا تتفرس في الواقعات
عواقبها ، فينظرون في أخف الضررين فيحتملونه .
وقد كشف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو غالب على الدهماء
حينذاك: الافتتان بحق الملكية والحرية الشخصية ، التي يظن أنها المطلقة
اليد ، تفعل فيما تملك ما تشاء ، فيرين على الألباب ، ما يطمس نورها ،
فتهتف الضلالة فيهم : « لو خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا » .
كلمات تقال ، تحمل في ظواهرها طيب المقاصد ، وحسن الدوافع ( في نصيبنا ) (
لم نؤذ من فوقنا ) كلما فاتنة ، تلقي بالغشاوة على البصائر فلا تنفذ في
عقبى الأشياء ، ولكن من تحت تلك الكلمات الطامة ، التي لا تبقي ولا تذر .
كلمات هي أصل الداء ، وجرثومة الفساد ، في كثير من الحياة . كلمات يغشى
بريقها البصائر فلا تفقه كنهها ، ولا يفقه قائلوها فلسفة الامتلاك في
الإسلام : ليس المرء بمطلق اليد فيما يملك بفضل الله تعالى . ثم يزعم أنه
يفعلها لكيلا يؤذي غيره ، وهو في حقيقة فعله لا يؤذي فحسب ، بل هو يدمر
ويمحق .
حين يستقيم تصور الإنسان حقائق الامتلاك في الإسلام ، تستقيم حركته وسلوكه
فيما يملك ، فيعلم أن لحرية التصرف فيما ملكه الله تعالى ، حداً يقف عنده
، لا يتعداه ، لأن في تعديه ضربا من الاعتداء على الآخرين .
« عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضدُ من نخله في حائط رجلٍ من
الأنصار ، قال ومع الرجل أهله . قال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به
ويشق عليه ، فطلب إليه أن يبيعه ، فأبى ، فطلب إليه أن يناقله ، فأبى ،
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر له ، فطلب إليه النبي صلى الله عليه
وسلم أن يبيعه فأبى ، فطلب إليه أن يناقله ، فأبى ، قال : (( فهبه له ،
ولك كذا وكذا )) أمراً رغبة فيه فأبى ، فقال : (( أنت مضار )) فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري : (( اذهب فاقلع نخله » .
فهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنَّ حرية تصرف المرء فيما يملك غير
مطلقة ، بل تحكمها ترك المضارة ، سواء ما كان منها جهالة ، وما كان منها
عمداً .
إن حال أهل السفينة كما صوره الرسول صلى الله عليه وسلم من الجلاء والبديهة العقلية والمسلمة الفطرية ما يجعله بعيداً عن الجدال ، أو التوقف فيه ، وهذا ما يجعل إقامته مقام المشبه به حال الدنيا ومن فيها : علائق ومسؤولية ، حقاً وواجباً ، أمراً يستوجب التسليم المطلق ، بأن حكم العقل في حال الدنيا ، ومن فيها ، حكم السفينة وأهلها : علائق ومسؤولية ، وحقاً واجباً ، وأن التوقف في ذلك خطيئة عقلية تقذف بصاحبها خارج أفق الإنسانية ، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم من بعد أن أبان علاقة القائمين على حدود الله في الدنيا ، بالواقعين فيها ، وبالمداهنين ، قد أقام الحجة على كل ذي عقل ، أنَّ صلاح المرء في نفسه غير كاف ، بل فريضة عليه أن يكون صالحاً ، وأن يكون مصلحاً ما حوله ، قائماً بالاحتساب والرقابة الراشدة على ما حوله ، فلا يدع أيدي العابثين ممتدة بالشر .
فأقام الإنسانية أمام فريضة تغيير المنكر ، ومنع أهله منه ،
والأخذ على أيديهم أيَّا كانت نياتهم ومقاصدهم ، قياماً لا تستطيع الفكاك
منه ، والتخلي عنه ، أو التوقف فيه ؛ لأن في هذا التوقف والتخلي إخراجاً
لها من أفق الإنسانية المسلمة وقذفا بها في حمأة الجاهلية وخبالها .
وهو صلى الله عليه وسلم باختياره عناصر المشبه به على هذا النحو ، أبلغ في
هدي الأمة إلى أنَّ فريضة تغيير المنكر ضرورة حياة ، لا ينظر فيها إلى
دوافع فعل المنكر ونوازعه ، فإن كثيراً من الماحقات قد يكون مبعثها حسن
نوايا الجاهلين الحمقى .
إن حسن النية وحده ، لا يثمر خيراً ولا يهدي إليه ، إلا إذا كان هذا الحسن
ثمرة علم وفقه ، وحكمه وبصيرة ، فأغلق بذلك البيان الباب ، في وجه من
يتوانى عن تغيير المنكر الواقع اغتراراً بحسن نوايا فاعليه .
وأغلقه في وجه من يتوانى عن التغيير ، اغتراراً بالحرية الشخصية ، التي
بدت في قول المداهنين (( إنما يخرق في نصيبه )) .
هذه المقابلة الإبليسية ( إنما يخرق في نصيبه ) إنما يرفعها
لواءاً جمهرة من المداهنين المرجفين في المدينة ، يدلسون بهذه الأغلوطة
الإبليسية ( الحرية الشخصية ) على الدهماء ، الذين يلهثون خلف كل ناعق ،
بما يرفع عنهم تكاليف الصلاح والإصلاح ، ويبهرج لهم أغلوطاته ، بما تشتهيه
نوازع الحيوانية فيهم . فما من مذهب فلسفي أو سياسي أو اجتماعي أو فني ،
أراد أن يضرب في الأمة المسلمة فيوهي بنيانها ، فيصرف الناس عن الاستمساك
بالهدي ، إِلا رفع شعاراً ( أغلوطة ) الحرية الشخصية : إنما يخرق في نصيبه.
هذه المذاهب وإن تغايرت وتناحرت فيما بينها ، منهجاً وحركة ، فالذي يوحد
بينها الرغبة الجموح ، في صرف الناس عن التعاون على تحقيق الوجود المتمكن
للأمة المسلمة ، فلا تجد فتنة في الناس أسرع وأنكى من أغلوطة الحرية
الشخصية.
جاء في ميثاق إِبليس : بروتوكولات حكماء صهيون :
(( كذلك كنا قديماً ، أول من صاح في الناس : (( الحرية والمساواة
والإخاء )) ، كلمات ما انفكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة ،
متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائر ، وقد حرمت بترددها العالم من نجاحه ،
وحرمت الفرد من حريته الشخصية الحقيقية ، التي كانت من قبل في حمى يحفظها
من أن يخنقها السفلة )) .
(( إن كلمة ( الحرية ) تزج بالمجتمع في نزاع مع كل القوى حتى قوى الطبيعة
وقوة الله )) .
وإذا ما كان النبي صلى الله علي وسلم قد هدى حين أخبر أنه ستكون فتنةُُ ،
فسأله الصحابة: فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : « كتاب الله فيه نبأ
ما قبلكم، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه
من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله » ، وهو ما استند
إليه وإلى غيره من آيات الله والحكمة ، أهل العلم والدعوة فتنادوا مخلصين
: الإٍسلام هو الحل ، إذا ما كان ذلك فإن المرجفين في الأمة الساعين في
الأرض فساداً يرفعون شعاراً (( الليبرالية هي الحل )) على الرغم من أن ((
الليبرالية قد اتخذت الحرية المطلقة الأساس شبه المقدس لها )) ، ومن
الحرية اشتق لها اسمها الكاشف عن حقيقتها وكنهها .
ما (( الليبرالية )) في حقيقتها إلا رفض سلطة الدين في شؤون
الحياة عقيدة وشريعة ومنهج حياة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، وإن
حاول بعض دهاقنتها ، خداع الدهماء ، في بيان حقيقتها ، بما لا ينفرهم منها
، فيبهرجونها في بادئ الأمر لهم ولا يقدمون لهم ، في مفتتح دعوتهم لها ،
ما يمكن أن تنتبه له بعض عقول الدهماء فينصرفوا عنها .
يزعم دهاقين (( الليبرالية )) الخارجة من عباءة (( الماسونية )) ، أن ((
الليبرالية )) دعوة إعلاء شأن الفرد وحريته في الاختيار ، والانتماء ،
والملكية ، والقرار ، وحقه في المشاركة في عقد اجتماعي ، يرتضيه في ظل
مجتمع ، يوفر كافة ضمانات الحرية بأشكالها الديمقراطية والتوازن الطبيعي
في المجتمع )).
كلمات يغشون بها على عقول كثير من الدهماء ، فيتمكنون منهم ويسعون بهم إلى تقويض الوجود المتمكن للأمة المسلمة ، ومن خلال تبني سياستهم القائمة على (( إطلاق الحرية الدينية كاملة ، وعادلة ، ومتساوية ، وبلا انحياز ، وأن الدولة مهمتها توفير الحرية لكل الأفراد ، وحماية مصالحهم المدنية ( كذا) وملكياتهم الخاصة ، وعلى السلطة عدم التدخل في الشؤون الدينية إلا إِذا كانت بعض الأعمال التي يقوم بها أصحابها بدعوى الدين ، تعد محرمة أو مجرمة أصلاً لأسباب غير دينية )) .
هكذا تكشف (( الليبرالية )) في دهاء يمزج السم بالعسل عن هدفها الأعظم ، فهي تؤمن وتدعو إلى أن ترفع الدولة يدها عن شؤون الدين الذي تعتنقه جمهرة الأمة ، فلا تنفق عليه من بيت المال شيئاً ، فيتساوى عندها الإسلام ، وسائر الديانات والمعتقدات ، ولا يكون للدولة معتقد ، تتبناه وتدعو إليه ، فالليبرالية تدعو إلى (( أن يبقى الدين علاقة بين الإنسان وربه )) لا يتعدى مجاله ما يعرف عند الدهماء بالطقوس الدينية في مناخاتها الزمانية والمكانية ، لا يتجاوز بها المسلم مسجده أو منزله ، وإلا كان خرقاً في (( الليبرالية )) يجب على الدولة أن تأخذ على أيدي من تسول له نفسه أن يفعل . وهم بذلك لا يبيحون للسلطة الحاكمة أن تنفق على أمر من شؤون الدين من الخزانة العامة ، وبدعوى أن الدين من الشؤون الشخصية للأفراد ، ينفق عليه من يعنيه ذلك ، وليس من شؤون السلطة والدولة ، وفي الوقت نفسه يجعلون مسؤولية الدولة العناية بما يسمى فنوناً وثقافة عالمية على اختلاف أنواعها وأهدافها ، ويلزمون الدولة الإنفاق عليها من الخزانة العامة ، وما ذاك إلا أن في تلك الفنون تحقيقاً لغاياتهم من تقويض الوجود المتمكن للأمة المسلمة .
ودعاة (( الليبرالية )) يتسللون من دعوة عدم التدخل في الشؤون الدينية من قبل الدولة إنفاقاً ورعاية ، إلى وجوب تصديها بالردع ، إذا كانت بعض الأعمال التي يقوم بها أصحابها بدعوى الدين ، تعد محرمة ، أو مجرمة أصلاً ، لأسباب غير دينية ، فهم يوجبون ـ تحت هذا الستار ـ مصادرة كل ما يستشعرون فيه اقتراباً من هيمنتهم على سُدَّة الحكم ، بدعوى أن في هذا اعتداء على حرية الأفراد ، أو دعوى التطرف .. إلى آخر تلك الأستار ، فكل ما لا يتناسق مع أهوائهم وأهدافهم ، يكون عندهم من الممارسات الدينية المحرمة ، أو المجرمة ، لأسباب غير دينية ، أمَّا ما كان محرماً لأسباب دينية جاءت بها الشريعة ، فلا دخل للسلطة فيها ، لأنها لن تمس أهدافها في تقويض الأمة المسلمة ، وهم يطلقون وصف التحريم والتجريم ، للممارسات الدينية ، لأسباب غير دينية ، ليتأتى لهم الحكم به على كل ما لا يروق لهم ، من شؤون الممارسات الدينية لدى المسلمين ، فتتحول كثير من الحقوق الدينية المشروعة للمسلمين مما جاء به الكتاب والسنة أعمالاً محرمة أو مجرمة لأسباب غير دينية تستوجب ((الليبرالية )) على السلطة الحاكمة التصدي لهذه الممارسات الدينية المشروعة أو
المفروضة بالكتاب والسنة ، وبهذا تتعانق (( الليبرالية )) مع
عدوها اللدود (( الماركسية )) التي تتستر الآن بعد انهيار الشيوعية
العالمية تحت ستار (( اليسار )) ، فيدعوان إلى التصدي لكثير من الممارسات
الدينية المشروعة بالكتاب والسنة .
وهذا الذي ينطلق منه دعاة الحرية الشخصية المطلقة التي هي الأساس المقدس
لليبرالية ، إنما هو عين ما جاء به ميثاق إبليس (( بروتوكولات صهيون )) :
(( إنَّ كلمة الحرية التي يمكن أن تفسر بوجوه شتى سنجدها هكذا : (( الحرية
حق عمل ما يسمح به القانون )) تعريف الكلمة هكذا ، سينفعنا على هذا الوجه
: إذ سيترك لنا أن نقول : أين تكون الحرية ، وأين ينبغي أن لا تكون ، وذلك
لسبب بسيط هو القانون ، لن يسمح إلا بما نرغب نحن فيه )) .
ودعاة (( الليبرالية )) يتسللون من خلال الخداع بأغلوطة حرية
الفرد في الاختيار والانتماء والملكية والقرار ، إلى حرية الطعن في الدين
باعتبار أن الدين ليس حقًّا شخصيَّا لفرد معين ، يعد الاعتداء عليه ،
والطعن فيه ، اعتداء على الآخرين ، وباعتبار أنَّ الدين موروث قابل للنظر
فيه ، والنقد له ، وهم في محاولتهم خرق السفينة ، بل إغراقها يعملون في كل
جانب ، وفي آن واحدٍ ، معتصمين في كل هذا بميثاق (( إبليس )) : ((
برتوكولات حكماء صهيون : يجتهدون في الاستهزاء بالسنة وأهلها وقرنها
بالخرافات وعدم صلاحيتها لتقدم الأمة ، ويضربون بها عرض الحائط لأنها لا
توافق أهواءهم وأهدافهم ، فيخرقون في السفينة خرقاً ماحقاً لا يبقي ولا
يذر .
ومنهم من يجتهدون في التضليل فيعمد إلى القرآن يقول فيه مقالة مارق ، وهي
شنشنة تعرفها الحياة الثقافية منذ (( طه حسين )) في كتاب (( في الشعر
الجاهلي )) ومحمد أحمد خلف الله في (( الفن القصصي في القرآن )) وتغريد
عنبر في (( دراسة أصوات المد في التجويد القرآني )) حتى نصر أبي زيد في كل
ما قذف به حياتنا الثقافية ، يخرق به في سفينة الأمة خرقاً مبيراً .
يقول نصر أبو زيد : (( إن النص في حقيقته وجوهره منتج ثقافي ،
والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين
عاماً ، وإذا كانت هذه الحقيقة تبدو بديهية ومتفقاً عليها ( كذا !! ) فإن
الإيمان بوجود ميتافيزيقي سابق للنص يعود لكي يطمس هذه الحقيقة البديهية
ويعكر ـ من ثم ـ إمكانية الفهم العلمي لظاهرة النص )) .
ويقول نصر أبو زيد : (( إن كلام الله قد تجسد في شكل ملموس في كلتا
الديانتين : تجسد في المسيحية في مخلوق بشري هو المسيح ، وتجسد في الإسلام
نصًّا لغويًّا في لغة بشرية هي اللغة العربية ، وفي كلتا الحالتين صار
الإلهي بشريًّا أو تأنسن الإلهي ، واللغة العربية في الوحي الإسلامي تمثل
الوسيط الذي تحقق فيه وبه التحول ، ويتمثل اللحم والدم ـ مريم ـ الوسيط
الذي تحقق التحول فيه وبه في المسيحية )) .
ويقول : (( وإذا كان الفكر الديني الإسلامي ينكر على الفكر
الديني المسيحي توهم طبيعة مزدوجة للسيد المسيح ، ويصر على طبيعته البشرية
، فإن الإصرار على الطبيعة المزدوجة للنص القرآني وللنصوص الدينية بشكل
عامٍ ، يعد وقوعاً في نفس التوهم ، وينتج التوهم في الحالتين عن إهدار
الحقائق التاريخية والموضوعية الملابسة للظاهرة )) .
وهذا قليل من كثير يحاول به خرق السفينة وإغراقها ، وآيات الإضلال
والإرجاف فيما نقلناه عنه ذات جلاء لا يتوقف معه أحد في إدراك فداحة ما
يرمي إليه القائل وأمثاله .
وهو فوق هذا لا يرضى أن تكون علاقة الإنسان بالله تعالى علاقة العبد بسيده ، لأن هذا عنده يجعل الإنسان مغلولاً دائماً بمجموعة من الثوابت التي إذا فارقها حكم على نفسه بالخروج من الإنسانية ، وليست هذه الرؤية ـ كما يقول ـ معزولة تماماً عن مفهوم (( الحاكية )) في الخطاب الديني السلفي المعاصر حيث ينظر لعلاقة الله بالإنسان والعالم من منظور علاقة السيد بالعبد الذي لا يتوقع منه سوى إذعان ـ كما يقول ـ وهو لا يرضى أن يذعن لله ، ومن ثم يهتف في الناس حاثاً على الثورة على الله ، وعلى القرآن قائلاً : (( قد آن أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر ، لا من سلطة النصوص وحدها ، بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمنا . علينا أن نقوم بهذا الآن ، وفوراً قبل أن يجرفنا الطوفان )) .
وهم يرفضون أن يحكم الوحي على الواقع وأن يحتكم إلى النص ، لأن
الاحتكام إلى النصوص الدينية في المسائل الاجتماعية والسياسية لا يؤدي إلى
ما يرونه خيراً لهم .. يقول (( عبد العظيم أنيس )) : (( إن أي إصلاح ديني
حقيقي في ظروف اليوم ، ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين ، والكرة
الأرضية بسبب ثورة الاتصال ، تكاد أن تتحول إلى قرية كونية كبيرة ، وفي
عصر ميثاق حقوق الإنسان العالمي ، أقول أي إصلاح ديني حقيقي لا بد ـ كنقطة
بدء أن يتخلى عن فكرة تحكيم النصوص الدينية في المسائل الاجتماعية
والسياسية ... )) .
وذلك إيماناً بما أعلنه د / حسن حنفي من أنه (( احتمينا بالنصوص ، فدخل
اللصوص )) ، وهو الذي ينادي متسائلاً في سخرية :
(( لماذا يكون الله أفضل من الإنسان ؟ ولماذا نقول حقوق الإنسان ولا نقول
حقوق الله ؟ لماذا يحكم الوحي على الواقع ؟ ولماذا لا يحكم الواقع على
الوحي ؟)).
هكذا يخرق في السفينة خرقاً ماحقاً .
ويأتي آخر يصدر ديوان شعر أسماه ( آية جيم ) يجعله خمسة فصول أو
قصائد ، يسمى كل قصيدة أو فصلاً ( سورة ) ويصدر الديوان بقوله : (( أعوذ
بالشعب من السلطان الغشيم باسم الجيم ) ، وكل ما فيه لا يعدو أن يكون
خبالاً ، كلا بل هو كيد شيطان رجيم ، لا يتأتى لأحد في رأسه ذرة عقل أن
يزعم أن فيه من الشعر أو النثر أو قول عاقل شيئاً .
ومن هُذائه أن كل ما عداه قد غبن حرف (( الجيم )) ، فجاء منصفاً له من غبن
الله ، ومن غبن العالمين ، يقول :
(( ثم كيف لم تفطنوا أيها الأدباء الفصحاء إلى أنه حتى في التراث الفصيح
لم يضطهد حرف مثلما اضطهدت (( الجيم )) ، وإلا فدلوني أيها الشعراء
النحارير على جيمية محترمة في الشعر العربي كله ......
ولعل ما قيل عن الشعر يصدق بفصَّه ونصَّه على القرآن الكريم فلسَّر ما
كرَّم القرآن حروفاً كثيرة ليس (( الجيم )) من بينها : كَّرم الصاد والقاف
والنون وكذلك الألف واللام والراء ، ولكن أحداً لا يعرف على وجه اليقين
لِمَ غَبَنَ ( كذا ) الجيم حقها ، وهي التي ترمز إلى ركن إسلامي ركين وهو
الحج ...... وإذا ما تركنا القرآن الكريم إلى ميدان المعاني العامة ألفينا
الحقائق نفسها تقريباً )) .
هكذا يغبن الله ـ جل جلاله ـ والعالمون حرف (( الجيم )) عند هذا
المرجف في المدينة ، ويأتي هو لينصفه من الله الغابن ـ تعالى الله عن ذلك
علوًّا كبيراً ـ ذلك أن هذا الجيم عنده (( ليست مجرد حرف ما في أبجدية ما
، بل هي أبجدية قائمة بذاتها . إنها سر الوجود وكماله الشخصي ، ذلك أن
الوجود جيمي بطبعه ، فهيهات لشيءٍ أو شخصٍ بغير فضل الجيم أن يوجد ،
فلتخضعوا إذن لقانون الجيم ..... ذلك أن كل عبارة بل كل كلمة بل كل حرف لا
يفلت مهما حاول من صبغة جيمية كامنة .... .
ولأن أطماعي كأجيامي لا حد لها ، فإنني لن أرضى بأقل من أن يعمد كل من كان
اسمه خالياً من حرف (( الجيم )) إلى تجييم اسمه ليصبح (( عليّ )) جليًّا ،
ويصبح (( كمال )) جمالاً ، أما من كان اسمه مزداناً بحرف الجيم ...فيعمد
إلى أن يجعل بقية الحروف كلها أجياما ، فيحدث لأول مرة في تاريخ اللغات أن
تتوحد الأسماء بينما تتمايز المسميات )) .
كذلك يكون الإبداع الشعري معولاً يخرق السفينة بل إعصاراً يحرق السفينة
ومن فيها .
وأدهى من ذلك وأمّر ما ختم به ( تلموده ) وأسماه (( السورة
الخامسة )) (( الجيم تجرح (( ، فقد أخرجها على نحو يستدعي إلى عقل القارئ
نمط بناء السورة القرآنية ، يستفتحها قائلا : (( أعوذ بالشعب من السلطان
الغشيم باسم الجيم والجنة والجحيم ومجتمع النجوم أنكم اليوم ستفجأون
...... ثم يقول : (( وما أدراك ما الجيم ، فإذا مزجنا الأجيام مزجاً ، ثم
مخجنا جُرْجَهُنَّ مخجا ، ثم مججناهن مجًّا ، قل يا أيها المجرمون ، إنكم
اليوم لفي وجوم )) ......
ثم يختم سورته الخامسة ، ويختتم (( تلموده )) قائلاً : (( الجيم جل جلالها
.
صدق الحرف الرجيم )) .
لن يكون إجرام وافتراء على الله والقرآن كمثل ما قال في تلموده ، ففاق
أستاذه (( عبد الوهاب البياتي )) حين قال في ديونه : (( كلمات لا تموت )) :
الله في مدينتي يبيعُه اليهودُ
الله في مدينتي مشرَّدُ طرِيدُ
أراده الغُزاةُ أن يكونَ
لهم أجيرا شاعرا قوادا
يخدع في قيثاره المذهَّبِ العباد
لكنه أُصيب بالجنون
لأنَّه أراد أن يصون زنابق الحقول
من جرادهم أرادَ أن يكون ))
كل ذلك وكثير غيره في مجالات عديدة ، ومؤسسات رسمية وغير رسمية ،
يجاهد أصحابه ، في أن يخرق في سفينة الأمة خرقاً ، بل يجاهدون في أن
يحرقوها حرقاً لا يبقي ولا يذر.
فكان فريضة على كل من يعلن أن في قلبه ذرة من إيمان بالله ورسوله صلى الله
عليه وسلم ، وانتساباً إلى الإسلام وأهله أن يقوم إلى تغيير هذا المنكر ،
وأن يأخذ على أيديهم من قبل أن يحرقوا أو أن يخرقوا : ولذلك قالها الرسول
صلى الله عليه وسلم مكلفاً محذراً : « فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا
، وإن أخذوا علي أيديهم نجوا ونجوا جمعياً » .
ولن تجد شأناً من شؤون الأمة الآن ديناً ، ودنيا ، إلا وجدت فيه من يجاهد
أن يخرق ، ومن يجاهد أن يحرق ، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة كلها
في وجه أولئك المفسدين في الأرض ، وحذرنا الدمار والهلاك الشامل للأمة ،
إذا نحن توانينا أو تقاعسنا أو تخاذلنا أو شغلتنا أموالنا وأهلونا عن ردع
أولئك المرجفين في الأمة الساعين فيها فساداً وهم اليوم كُثْر، لهم من ذي
سلطان عون ، ولهم من الدهماء عجبٌُ .
(( عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : « يا أيها
الناسُ إِنكم تقرأون هذه الآية : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
} . فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن الناس إِذا
رأَوا الظالم فلم يأخذوا علي يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده » .
إن قول الله تعالى : { عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ } لا يستقيم فهمه على أنَّ
المعنى فيه : الزموا صلاح أنفسكم ، ولا شأن لكم بفساد غيركم ، فإنهم لا
يضرونكم في شيء فإِن فسادهم وبالُُ عليهم هم أنفسهم ، وأنتم منه ناجون .
لا يصح أن يكون هذا هو معنى قوله تعالى : { عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ } لأن
ذلك متناقض مع دلالات صريحة لآيات أخرى . ومن النصيحة لكتاب الله تعالى أن
تفسر آياته بعضها في ضوء بعض وفي ضوء السنة . وهذه الآية من حقها أن تقرن
بقول تعالى :
{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا
تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }{ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ
اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } ( آل عمران : 102 ـ 103 ) .
قوله أولاً { اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ } يوجب أول ما
يوجب صلاح الذات وكمالها . وقوله ثانياً : { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ
اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } يوجب إصلاح الآخرين وإعانتهم على
الكمال . ولذلك جاء قوله ( جميعا ) وقوله ( لا تفرقوا ) فلا يكفي أن يكون
الإنسان معتصماً بحبل الله وحده دون أن يكون اعتصامهم به جميعاً .
الصحيح في فقه قوله : { عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ } أن لمعناه مجالين :
مجال علاقة المسلم بأخيه المسلم ، ومجال علاقة الأمة المسلمة بغيرها من
الأمم الأخرى .
أما المجال الأول فإن المعنى القويم : أنَّ عليكم أنفسكم
بإصلاحها وتهذيبها وتثقيفها بثقافة الدعوة إلى الله فكراً وسلوكاً
وتدريبها على حسن التعليم وحسن الصبر على الدعوة وابتلائها ، والاحتساب
لوجه الله ، لتكمل خصال أنفسكم المسلمة ، فإذا ما تحقق ذلك فإنه لن يضركم
من ضل عند دعوتكم له إلى الحق بالحسنى ، وإن كان قويَّا متسلطاً ، فإنكم
ستكونون بإصلاح أنفسكم على النحو الذي مضى ، قد هذبتموها ، وحصنتموها ،
ودربتموها فلا ينال منكم من ضل إذا اهتديتم إلى حسن إعدادها وتدريبها ،
وقيامها ، بما عليها من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قولاً
وسلوكاً .
أمَّا المجال الآخر : مجال علاقة الأمة المسلمة بغيرها من الأمم ، فإنَّ
المعنى إنكم يا أيها الذين آمنوا أمة واحدة ، منفصلون عمن سواكم متضامنون
، متكافلون فيما بينكم ، فعليكم أنفسكم . عليكم أنفسكم فزكوها ، وطهروها ،
وعليكم جماعتكم فالتزموها ، وراعوها ، ولا عليكم أن يضل غيركم إذا أنتم
اهتديتم ......
إن هذه الآية تقرر مبادئ أساسية في طبيعة الأمة المسلمة ، وفي طبيعة
علاقتها بالأمم الأخرى ......
إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله ، لا يضيرها من
ضل إذا اهتديت ، لا يعني أنها غير محاسبة على التقصير في الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر فيما بينها أولاً ثم في الأرض جميعاً ......
إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد ، ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر ،
ومقاومة الضلال ، ومحاربة الطغيان ، وأطغى الطغيان الاعتداء على ألوهية
الله ، واغتصاب سلطانه ، وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته ، وهو المنكر
الذي لا ينفع الفرد ولا ينفع الأمة أن تهتدي ، وهذا المنكر قائم )) .
وإذا لم يقم كل منا أفراداً وأمة بتغيير هذا المنكر ، فإن الدمار هو عقبى
السوء ، وذلك بينها الصديق عليه الرضوان بعد أن أشار إلى ضلال فهم الناس
الآية فقال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الناس
إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده » .
فتغيير المنكر فريضة لأنه ضرورة حياة ، به يتحقق للأمة وجودها الآمن ،
وإلا عمهم الله بعقاب من عنده : { وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ } ( الأنفال : 25) .
وقد فسرها (( ابن عباس )) رضي الله عنهما بقوله : (( أمر الله
المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم ، فيعمهم الله بالعذاب )) .
وقد جاءت أحاديث عدة تحذر سوء عقبى السكوت عن المنكر ، والإعراض عن تغييره
، أو الانشغال عن هذا التغيير .
« عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم
فغرفت في وجهه أن قد حضر شيء ، فتوضأ وما كلم أحداً ، فلصقت بالحجرة ،
أسمع ما يقول ، فقعد على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه وقال : يا أيها
الناس ، إن الله يقول لكم مُرُوا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، قبل أن
تَدْعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم ، وتستنصروني فلا أنصركم » .
(( وعن عبد الله بن جرير عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : « ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي ، يقدرون على أن
يُغيروا عليه ، فلا يغيروا ، إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا » .
« عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : إنَّ أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل ،
فيقول : يا هذا ، اتق الله ودع ما تصنع ، فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من
الغد ، فلا يمنعه ذلك ، أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب
الله قلوب بعضهم ببعض )) ، ثم قال : { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ } إلى
قوله { فَاسِقُونَ } ثم قال : كلا ، والله ، لتأمُرُنَّ بالمعروف ،
ولتنهونَّ عن المنكر ، ولتأخُذُنَّ على يدي الظالم ، ولتأطرنَّه على الحق
أطراً ، ولتقصرُنَّه على الحق قصراً » .
وفي رواية زاد : « أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعضٍ ثم ليلعَننّكم كما
لعنهم » .
(( عن جابر أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أوحى الله عز
وجل ـ إلى جبريل ـ عليه السلام ـ أن أقلب مدينة كذا وكذا بأهلها ، فقال :
يا رب إنَّ فيهم عبدك فلاناً لم يعصك طرفة عين . قال : فقال : اقلبها عليه
فإن وجهه لم يتمعَّر فيّ ساعةً قطُّ » .
وفي هذا دلالة باهرة على أن الاكتفاء بالصلاح الذاتي والاعتصام
من مشاركة المفسدين إفسادهم ، لا يقي المرء من الهلاك إلا إذا جمع إليه
تغيير المنكر الواقع ممن حوله ، بكل ما يمكن تغييره به فله النّجاءُ .
(( عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: أقبل علينا رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال : « يا معشر المهاجرين ، خمس إذا ابتليتم بهن ـ وأعوذ
بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا
فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا
المكيال والميزان ، إلا أُخذوا بالسنين ، وشدة المؤونة ، وجور السلطان
عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم ، إلا مُنعوا القطر من السماء ، ولولا
البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله ، إلا سلَّط الله
عليهم عدوّا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب
الله ، ويتخيروا مما أنزل الله ، إلا جعل الله بأسهم بينهم » .
هذه المهلكات الخمس ، هي فينا شاخصة ، تكاد تراها حيث وقع بصرك.
وإن من عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الأخذ على أيدي
الظالمين والمفسدين في الأرض ، والمرجفين في المدينة ، فإن لم نفعل سلَّط
الله علينا عدواً من غيرنا وقد فعل ، فأسامنا ذُلاَّ لم تشهد الأمة مثله
منذ كانت.
إن تغيير المنكر ، والأخذ على يد الظالم ، وردع المفسدين ، هي الفريضة
الموءودة في أمتنا.
ولن تستقيم حياة أمة بغير القيام بها قياماً ناصحاً ، فالتغيير ضرورة حياة
، وهو في الإسلام لا يبتغى به إلى عرض من أعراض الحياة الدنيا.
إن غاية تغيير المنكر ، تحقيق الوجود المتمكن للأمة المسلمة ، لتأخذ بيد
الحياة كلها إلى ما فيه خير الإنسان والوجود كله على هذه الأرض ، فيعم
السلام والخير تحت راية الإسلام الذي ارتضاه الله ـ تعالى ـ للعالمين
ديناً.
الفصل الثاني
التغيير ضرورة وغاية
بيان النبوة وسائل التغييربيان المنكر الواجب تغييره : الحقيقة والشروط
بيان التغيير : حقيقته وشروطه
بيان المغيّر المنكر شروطه وآدابه
بيان الواقع في المنكر شروطه وأحواله
بيان وسائل التغيير : مراتبها وآدابها
تغيير المنكر باليد : أحواله وآدابه
تغيير المنكر باللسان : أحواله وآدابه
تغيير المنكر بالقلب : أحواله وآدابه
العجز عن التغيير باليد أو اللسان
إن وجود المنكر في المجتمع أمر طبيعي ، لا يخلو منه مجتمع في أي حقبة من حقب الحياة ، ولكن الذي ليس من الطبيعي أن يرى أبناء المجتمع المنكر ، فلا يسعون إلى تغييره (!) ، وفي التغيير بقاءُ الحياة على النحو الذي يحبه الله عز وعلا .
ولما كانت غاية تغيير المنكر عظيمة ، وكان فريضةً وضرورة حياة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين منهاج التغيير وآلياته ووسائله ، والضوابط والآداب ، حتى لا تضل الأمة في قيامها بتلك الفريضة ، فتسلك بها غير السبيل القويم ، أو تتخذ وسيلة غير التي تكون لها .
وبيان النبوة لوسائل (( تغيير المنكر )) وضوابطه ، يقيم الأمة على المحجة البيضاء ولا يبقي لها عذراً في التقاعس أو التكاسل عن القيام بهذه الفريضة ، فكان البيان شافياً شاملاً ، لا يكاد يفلت منه واحد من الأمة ، مهما كان موقعه في الحياة ، ومهما كانت قدرته واستطاعته ، مما يدل على أن منزلة (( تغيير المنكر )) ، من مقومات شخصية المسلم ، الذي به قيام الأمة المسلمة .
بيان النبوة وسائل التغيير
(( عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » ( رواه مسلم ) .الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه (( مسلم )) والأربعة وأحمد قد بين السبل ، التي يسلكها المرء إلى التغيير ، فصدّوه بقوله : « من رأى منكم منكرا فليغيره » ثم بين آلات التغيير وسبله من بعد ذلك ، ناظماً لها نظماً أولياً ، فلا يتخلى المرء عن سبيل ، إلى الذي بعده ، إلا إذا أعذر نفسه ، وأيقن أن ليس في طوقه القيام بالتغيير من خلال السبيل الذي ترك .
ولبيان ما هدى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً مفصلاً يجلّي الدقائق ويحرر القول ويفصل المشتجرات حتى لا يبقى عذر لمعتذر ، سيكون بياننا على النحو التالي :
· بيان المنكر : حقيقته وشروطه .
· بيان التغير: حقيقته وشروطه .
· بيان المغَيَّر : شروطه وآدابه .
· بيان ذي المنكر وشروطه .
· بيان وسائل التغيير : شروطها وآدابها .
بيان المنكر الواجب تغييره : الحقيقة والشروط
كلمة ( منكر ) بضم الميم وسكون النون ، وفتح الكاف ( مُفْعَل ) مثل (
مُكرم ) اسم مفعول من ( أُنكرِ ) المبني لما لم يسم فاعله ، أي جُهِل ولم
يعرف .
وقد اختلفت عبارة أهل العلم في بيان حقيقة المنكر ، فمنهم من عرَّفه بما
هو أعلى صوره ، ومنهم من عرفه ببعض صوره ، فلم تكن التعاريف كاشفة عن
حقيقة وماهية المنكر الواجب تغييره .
ذهب (( أبو العالية )) إلى أن المنكر عبادة الأوثان ، وهذا أعلى أنواع
المنكر ، ولا يتصور أنه يقصر حقيقته عليه ، فإنه من العلم والحكمة بمكان
عظيم .
ومساق الحديث من رواية (( أبي سعيد )) ، دالُُ على أن المنكر الذي قام رجل
لتغييره ، ليس من عبادة الأوثان ، وإنما هو تقديم خطبة العيد على الصلاة .
ولذلك قال (( الفخر الرازي )) : رأس المنكر الكفر . فجعله رأس المنكر ،
وما عداه من الكبائر دونه وداخل في المنكر .
وقال الجصَّاص في (( أحكام القرآن )) : المنكر هو ما نهى الله عنه .
وقال الألوسي : المنكر المعاصي التي أنكرها الشرع .
وقال علي القاري : المنكر ما أنكره الشرع وكرهه ولم يرض به .
وقال الراغب الأصفهاني : (( المنكر كل فعل تحكم العقول الصحيحة
بقبحه ، أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول ، فتحكم بقبحه الشريعة )) .
والذي نذهب إليه أن (( المنكر )) الذي يجب على الأمة تغييره ، هو ما خالف
الشرع كتاباً وسنة مخالفة قاطعة .
وسواء في هذا ، أن تكون المخالفة لما أمر به الشرع إيجاباً أو لما نهى عنه
تحريماً ، وسواء كانت المخالفة تركاً بالكلية ، لما أمر به الشرع أو زيادة
عليه بغير نص ، أو نقصاً منه بغير عذر ، أو تغييراً فيه ، أو تبديلاً في
ذاته ، أو فيما يتعلق به زماناً أو مكاناً أو كيفية أو وسيلة . فكل مغايرة
ذاتية أو عريضة فيما أمر به الشرع هي منكر ، ومثل ذلك تماماً المخالفة
بالفعل لما نهى عنه ، مخالفة كلية أو غير كلية .. إلخ .
وسواء في هذا ـ أيضاً ـ أن يكون الأمر أو النهي تصريحاً ، أو تلويحاً ،
تفصيلاً أو إجمالاً .
تلك حقيقة المنكر الذي يجب على الأمة تغييره ، وهو يشترط فيه
شروط أهمها : *أن يكون المنكر متفقاً على إنكاره لثبوته بالكتاب أو السنة
، بحيث لا يكون إنكاره محل خلاف بين أهل العلم الموثوق بهم من ذوي
الاختصاص والتقوى فإن كان محل اجتهاد واختلاف ، فليس مما يجب على الأمة
تغييره ، بل يكون لمن ذهب إلى أنه منكر على الراجح عنده وأن يدعو إلى تركه
من باب النصيحة إلى ما هو الأعلى والأليق بالمسلم .
وغير قليل من أحكام الشريعة المستمدة من الكتاب والسنة بغير طريق العبارة
والمنطوق ، هو مناط اختلاف بين أهل العلم .
وكل ما أدى إلى منكر محقق هو نفسه منكر ، يجب تغييره ، فمن تيقن أن هذا
العنب لا يزرع إلا ليصنع خمراً ، كانت زراعة العنب بهذا الغرض منكراً فوجب
تغييره ، ومن تعلم الطب ليؤذي المسلمين ، أو يكشف عورات نسائهم ، كان
تعلمه الطب منكراً ، يجب تغييره ... إلخ
وتحقيق هذا الشرط من الأمور المهمة ، التي قد يتساهل فيها بعض الناس ، فإن
تحقيقه على الوجه الصحيح ، لا يكون إلا ممن جمع بين العلم والحكمة ، إذ
العلم يحقق له الوقوف على وجوه الدلالة في النصوص ، ووجوه اصطفاءات الأئمة
، والوقوف على دقائق العلم .
والحكمة تحقق له سعة الأفق ، ونفاذ البصيرة ، إلى عقبى الأحداث ،
فلا يغتر برأي فطير ، عليه مسحة من زخرف القول ، أو وهج الحماسة ، واندفاع
الشبيبة ، بل يكون له من الحكمة والروية ، ما يجعله يقف على حقائق الأشياء
.
وإذا ما كان تحقيق الوقوف على ما اتفق عليه أئمة أهل العلم ، وما اختلفوا
فيه من الكدى التي لا يكاد يجتازها إلا الخاصة فكيف بتحقيق الحكمة مع ذلك
؟ إنَّ غير قليل ممن استطاع التفوق في فقه الدين ، فقه تصور ، ليفتقر إلى
كثير من الحكمة في توظيف هذا الفقه ، توظيفاً مثمراً متناغياً مع الفطرة
الصافية ، وحركة الحياة المسلمة .
· أن يكون المنكر موجوداً متيقناً ، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم
: « من رأى منكم منكرا فليغيره » فقوله ( رأى ) دال على وجوب العلم بوقوع
المنكر ، علماً محققاً ، أو بإقدام صاحبه عليه لا محالة ، كأن يتيقن أنه
يدبّر لقتل آخر أو لشرب خمر ... إلخ . وأن الشواهد والقرائن قاطعة بعزمه
على إيقاعه ، فإن من المنكر ما يكون تغييره بمنعه منه ، قبل وقوعه ، بأي
سبيل من سبل المنع المشروعة ، وهو في هذا يكون أقرب إلى النهي عن المنكر ،
منه إلى تغييره ، فإن النهي أعم من التغيير .
ويستوي في المنكر الواجب على الأمة تغييره ، أن يكون مما يتعلق
بحق الله تعالى ، أو بحق أحد من عباده ، ويستوي ـ أيضاً ـ أن يكون ذلك
المنكر قولاً أو فعلاً ، كبيراً أو صغيراً ، فكل ما أنكره الشرع يجب
تغييره ، وإن اختلفت وسائل التغيير .
وقد جاء لفظ المنكر في الحديث نكرة ، ليكون عاماً ، فإنَّ النكرة في سياق
الشرط تعم ، مثلما تعم ، في سياق النفي ـ كما هو معلوم عند أهل العلم .
ويستوي في هذا أن يكون هذا المنكر واقعاً من كبير أو من صغير ، ذكر أو
أنثى ، فلو أن صغيراً أراد أن يقتل ، أو يشرب خمراً ، أو أن يحرق ماله ،
فإنه يجب منعه ، وإن كان غير مكلف ، وكذلك المجنون ، لو أقدم على منكر ،
منع منه ولا سيما منكراً يتعلق بحقوق الآخرين . فلا عبرة بمن يقع منه
المنكر ، بل العبرة بالمنكر نفسه ، وتحقق أنه منكر لا رخصة لمن يفعله فيه
. ولذا جاء المفعول الثاني للفعل ( رأى ) محذوفاً ، ليدل على العموم ،
فكأنه قيل : من رأى منكم منكراً واقعاً من أحد من الناس .
ذلك ما يهدي إليه النصح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
تدبراً وتأويلاً ، وليس صحيحاً ما ذهب إليه بعض الناظرين في الحديث من أنه
مقيد بالنفس ، ومن له عليه ولاية ، فيكون التقدير من رأى منكم منكراً من
نفسه ، أو أهله ، فيغيره ، فيكون التغيير محصوراً جوازه في منكر واقع من
نفس المغيّر أو أهله ، الذين له عليهم ولاية ، كما يذهب إليه مؤلفو كتاب
(( مواجهة الفكر المتطرف في الإسلام )) فذلك غير صحيح ومن ورائه شر مستطير
، إذا أنه يفتح الباب لمن ليس لأحد عليهم ولاية ، كالسلطان الأعلى وبطانته
، أن يقترفوا من المنكر ما شاءوا ، فليس لأحد ـ بناء على اجتهاد أولئك
المؤلفين ـ أن يغير منكرهم . وتلك التي لا يقول بها عاقل .
· أن يكون المنكر بواحاً ظاهراً ، لا يحتاج اليقين بعلمه إلى تفتيش وتجسس
، وسواء في هذا أن يكون ظهوره بذاته ، أو بما اقترن به ، من صوت ، أو لون
، أو رائحة ... إلخ . فكل منكر دلت عليه آياته ولوازمه ، هو من المنكر
الظاهر، الذي يجب تغييره .
أما إن كان المنكر خفيَّاً ، يقترف سراً ، فلا يستقيم التفتيش عنه .
(( عن أبي برزة الأسلمي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانُ قلبه ، لا تغتابوا
المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من اتَّبع عوراتهم ، يتَّبع الله
عورته ومن يتَّبع الله عورته يفضحه في بيته » .
يقول (( الماوردي )) : (( ليس للمحتسب ، أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات
فإن غلب على الظنَّ استسوار قوم بها ، لأمارة وآثار ظهرت ، فذلك ضربان :
أحدهما : أن يكون ذلك في انتهاك حرمة ، يفوت استدراكها ، مثل أن يخبره من
يثق بصدقه ، أن رجلاً خلا برجل ليقتله ، أو بامرأة ليزني بها ، فيجوز له
في مثل هذا الحال ، أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذراً من فوات ما لا
يستدرك ......
الضرب الثاني : ما قصر عن هذه الرتبة ، فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف
الأستار عنه ، فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة ، من دارٍ ، أنكرها خارج
الدار ، ولم يهجم عليها بالدخول ، لأن المنكر ظاهر فليس عليه أن يكشف عن
الباطن )).
وثمَّ منكرات أعظم أثراً في الأمة من غيرها كمنكر إشاعة الفتنة في الأمة لتقويض هيبة السلطان المسلم ، والخروج عليه ، وكمنكر استراق أسرار الدولة وأخبارها لنقلها للعدو ، وكمنكر التآمر على إفساد اقتصاد الأمة ، وثقافتها وعقيدتها ، وصحة أبنائها ، والتآمر على إشاعة الفاحشة في الأمة وتغييب عقول أبنائها ، وتزوير ، إرادة الأمة في اختيار ممثليها في المجالس النيابية ، وغيرها ، من المنكرات ، ذات الأثر الجسيم المبير .فمثل هذه المنكرات يجب اتخاذ السبيل إلى تغييرها ومنعها من قبل وقوعها ، وهو مما يبيت له بليلٍ ، ولا يكون مجاهرة .
فالتجسس والتفتيش منهي عنه في المنكرات ذات الآثار الفردية
الشخصية التي لا يكاد يتعدى أثرها الفادح إلى كثير من الآخرين ، أما ما
كان من المنكرات مبيراً ماحقاً عزة الأمة وقوتها ، فذلك يجب اتخاذ السبل
إلى تغييرها ومنعها من قبل وقوعها ، فعموم قوله تعالى : { وَلَا
تَجَسَّسُوا } ( الحجرات : 12 ) ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : « إياكم
والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تحاسدوا ،
ولا تدابروا ، ولا تباغضوا ، وكونوا عباد الله إخوانا » إنما هو عموم نهي
عن التجسس مخصص بما كان من المنكرات التي يكون أثرها فادحاً ومقوضاً لهيبة
الأمة وعزتها ، وسلامتها ، بحيث يكون ذلك المنكر أعظم جرماً من التجسس .
تلك أهم شرائط المنكر الذي يجب على الأمة تغييره .
بيان التغيير : حقيقته وشروطه
التغيير يقال على وجهين : ( أحدهما ) لتغيير صورة الشيء دون ذاته (
والثاني ) لتبديله بغيره ، نحو غيرت غلامي ودابتي ، إذا أبدلت بهما غيرهما
.
قاله الراغب في المفردات .
فالأصل في التغيير استبدال شيء مرغوب فيه ، بشيء مرغوب عنه ، فهو ليس
تركاً وإزالة فحسب ، بل يتبعهما إقامة غيره مقامه ، فيكون التغيير أخصّ من
الإزالة ، وأخصّ من النهي عن الشيء .
والحديث قد جاء بالأمر بتغيير المنكر ( فليغيره ) ، وهو أقرب إلى معنى
الإزالة إن كان موجوداً قائماً ، وإلى المنع منه ، إن شارف على الوقوع ،
وليس ظاهر الحديث آمراً بإزالة المنكر ، وإقامة معروف مقامه ، وإن كان
يغلب تعاقب أحدهما الأخر ، فحيث غاب المنكر ، كان المعروف ، وحيث غاب
المعروف ، كان المنكر .
وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال : ( فليغيره ) ، يهدي إلى أن تمام
الفريضة وكمالها بإقامة معروف مقام ما يزال من المنكر ، حتى لا ندع للمنكر
مجالاً للعود ، فهو لم يقل: من رأى منكم منكراً فليزله ، أو فليمنعه ،
وإنما فليغيره.
وإذا نظرنا فيما تعلق بهذا الفعل من وسائله وآلاته ( بيده ،
بلسانه ، بقلبه ) ألفينا دلالة التغيير ، تتجدد بتجدد ما تعلق بها فغير
خفي ، أن التغيير باليد ليس هو التغيير باللسان ، فاللسان ليس بآلة إزالة
ومنع ، بل هو سبب له ، وكذلك (القلب) ، ولكن ( اليد ) قد تكون آلة إزالة
وتغيير حقيقي .. فحقيقة تغيير المنكر ، تختلف باختلاف وسيلته ، وباختلاف
المنكر الذي يقع عليه ذلك التغيير ، وباختلاف من يقوم بذلك التغيير .
وللتغيير شرائط وآداب نذكر منها :
· أن يكون التغيير إيماناً واحتساباً وابتغاءً لمرضاة الله عز وعلا ، في
تحقيق الوجود المتمكن للأمة المسلمة الفاعلة الرائدة ، وليس تغييراً
لعصبية قومية ، أو وطنية ، أو لغوية ، أو حزبية، أو تحقيقاً لهوى في النفس
، أو موافقة لما تحب .
فهذه غايات قد يقع تغيير المنكر من أجلها ، فيكون هذا التغيير في نفسه
منكراً يحتاج إلى تغيير .
أما التغيير الذي هو عبادة ، فإنما هو الخاص لوجه الله تعالى ،
لا يبتغى به غيره { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ } ( البينة : 5 ) ، والله سبحانه
وتعالى ، قد بين لعباده غناهُ عن الشركاء في حديثه القدسي :
« أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه
» .
وحين يكون هذا التغيير احتساباً ، يُعينُ الله القائم لهذا التغيير ، على
الاستعداد له ، استعداد قلبياً وعقلياً ونفسياً وجسدياً ومالياً ، لأن
لهذا التغيير تبعات جساماً وابتلاءات عظاماً ، لو لم يكن القائم له
محتسباً وجه الله تعالى ، لنكص على عقبيه أو تقاعس عن إنفاذ ما بدأ ، وهذا
ما يهدي إليه قوله تعالى في بعض وجوه دلالته المتكاثرة : { يَاأَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ
إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } (المائدة : : 105) فإن من الاهتداء المشروط لانتفاء
أضرار الضالين من يقوم بالتغيير أن يكون عملهم مخلصاً لله تعالى ، بل ذلك
رأس الاهتداء .
· أن يكون التغيير موافقاً هدي الكتاب والسنة . ذلك أن كل عمل
صالح أساسه أمران : إخلاص النية وموافقة الشرع .
(( ولهذا كان أئمة السلف ـ رحمهم الله ـ يجمعون هذين الأصلين ، كقول ((
الفضيل بن عياض )) في قول تعالى : { لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا } ( الملك : 2 ) قال : أخلصه ، وأصوبه . فقيل : يا أبا علي ، ما
أخلصه وأصوبه ؟ فقال : إِنَّ العمل إِذا كان صواباً ، ولم يكن خالصاً ، لم
يقبل ، وإذا كان خالصاً ولم يكن صواباً ، لم يقبل ، حتى يكون خالصاً
صواباً . والخالص أن يكون لله ، والصواب أن يكون على السنة .
وقد روى (( ابن شاهين )) واللالكائي ، عن سعيد بن جبير قال : لا يقبل قول
وعمل إلا بنية ، ولا يقبل قول وعمل ونّية إِلا بموافقة السنة )) .
وموافقة الشرع ، لا تكون إلا عن علم ومعرفة ، وإذا كنّا قد ذكرنا ضرورة
العلم بحقيقة المنكر المراد تغييره ، فإن الشرط هنا معرفة كيفية التغيير ،
وفقاً لهدي الشريعة ، وهذا يستوجب معرفة أسباب المنكر المراد تغييره معرفة
كاشفة ، ومعرفة آثاره العاجلة والآجلة في الأمة .
ومعرفة ما يحيط بوجود المنكر ، وانتشاره في الأمة من ملابسات ،
وما يعين على بقائه أو تجدده ، أو إغراء الناس بالانشغال به ، أو التلبس
والتردي فيه ، أو السكوت على أهله ، أو إجلالهم ، أو الخوف من تغييره أو
إنكاره .
ويستوجب معرفة ما يترتب على تغييره ، بأي سبيل من آثار إيجابية ، أو سلبية
، والموازنة بين هذه الآثار ، فيما يحسن اختيار المنهج ، والزمان ،
والمكان والمقدار ، الذي هو أنفع للأمة ، عنده تغييره .
ويستوجب معرفة السبيل القويم ، إلى تغيير هذا المنكر ، تغييراً نافعاً ،
فيختار ما هو أكثر نفعاً ، وأقل ضرراً على الأمة ، وما هو أقدر على القيام
به ، وأصبر على إنفاذه .
ويستوجب معرفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر ، وفقاً
لطبيعة هذا المنكر ومنزلته في الاعتداء على حق الله تعالى ، أو حق عباده ،
ووفقاً لحال من يتلبس به ، وأسباب تلبسه ، وغايته من ذلك التلبس ...
إن القصور في معرفة شيء من ذلك ، تكون آثاره فادحة ، وإتقان معرفته تعين
على حسن على القيام به .
وهذه المعرفة عمل جماعي ، يتركز على الصبر والمصابرة ، والتواصي بالحق
والنصيحة ، وحسن العزيمة ، والرغبة الجموح في إتقان العمل .
إن الجهد الفردي جهد قاصر في هذا ، وهو إن لم يك عقيماً ، إلا أن
ثمرته غير نافعةٍ النفع المرجو من مثلها ، ولذلك دعا الله عز وجل الأمة
إلى الاعتصام بحبله جميعاً ، ونهي عن التفرق في تحقيق هذا الاعتصام : {
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } ( آل عمران
: 103 ) فهو ما أمر بأن يعتصم كل فرد منا بحبل الله على حياله ، دون
اجتماع مع الآخرين . وقوله : { وَلَا تَفَرَّقُوا } معناه : (ولا تعتصموا
بحبله متفرقين ) ، فهو من عطف جملة على جملة ، وليس عطف فعل على فعل .
وقد دعا عباده إلى التعاون على البر والتقوى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } ( المائدة : 2) ودعاهم إلى التواصي بالحق وبالصبر
: { وَالْعَصْرِ }{ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ }{ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ } ( العصر 1 ـ 3 ) .
روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : (( لو فكر الناس كلهم في
سورة العصر لكفتهم )) ، وهو كما قال ، فإن الله أخبر فيها أن جميع الناس
خاسرون ، إلا من كان في نفسه مؤمناً صالحاً ، ومع غيره موصياً بالحق
موصياً بالصبر )) .
ولم يرض الله أن يكون المسلم صادقاً فحسب ، بل دعاه إلى أن يكون مع
الصادقين { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا
مَعَ الصَّادِقِينَ } ( التوبة : 119 ) .
هذه المعية المنبعثة من الصدق مع الله تعالى ، ومن اتَّقائه ، هي السبيل
إلى القيام بتحقيق الوجود المتمكن للأمة المسلمة ، وهي التي لا ترضي
الطغاة والمفسدين في الأرض ، لأنّ فيها الوقاء من كيدهم ومكرهم .
· أن يسلك بالتغيير منهج التدرج والحكمة والحلم والرفق ، ليكون ذلك أنجح
وأنجع.
وأول تلك المراحل تعريف صاحب المنكر بحكم فعله وآثاره وعواقبه في الدنيا
والآخرة ، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة .
إن أو ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو تعليم الناس الخير
، والسبيل إليه ، والشر والسبيل إلى الاعتصام منه ، وحث على ذلك التعلم
وحمده . فإن كثيراً من العامة يقدمون على المنكر ، ويتردون فيه جهالة به
وظنَّا أنه مما لا بأس به ، فإذا ما عُلَّم بالحكمة ، ووعظ بالحسنى ، كان
أبعد عن المنكر وأنفر منه : { وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا
إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ }
( فصلت : 33 ) . وقد أمر الله عز وعلا أن تكون الدعوة إليه بالحكمة
والموعظة الحسنة : { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ } ( النحل : 125 ) .
ومن الدعوة إلى سبيله ، تغيير المنكر . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
رؤوفاً رحيماً بأمته ، يشفق على الطائع والعاصي ، وهو القائل : « إنما أنا
لكم بمنزلة الوالد أُعلَّمكم » ... )) ، وفي قصته مع الأعرابي الذي بال في
مسجده القدوة والأسوة في حسن تعليم الجاهل ، حين يقع في منكر .
عن أنس بن مالك قال « بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم إِذ جاء أعرابي ، فقام يبول في المسجد ، فقال أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم : مَهْ مَهْ . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: (( لا تُزْرِمُوه . دعوه )) ، فتركوه حتى بال . ثم إن النبي صلى الله
عليه وسلم دعاه ، فقال له : (( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول
، ولا القذر ، إنما هي لذكر الله عز وجل ـ والصلاة وقراءة القرآن » أو كما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : « فأمر رجلا من القوم ، فجاء
بدلو من ماء فشَنَّه عليه » . وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لأصحابه عندما زجروا الأعرابي : « فإنما بعثتم مُيسَّرين ، ولم تُبعثوا
مُعسَّرين » .
ولذلك لما تفقه الأعرابي ، بما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال
واصفاً حلم النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه : « فقام إلي ـ بأبي وأمي ـ
فلم يؤنّب ولم يَسُب » .
ما اقترفه الأعرابي منكر لا شك فيه ، من وجوه كثيرة ، أعلاها حرمة مسجد
النبي صلى الله عليه وسلم ، وحضرته ذلك الفعل .
وما اقترفه الأعرابي لا يحتاج العلم بأنه منكر ، إلى معرفة خاصة
، فالفطرة تأباه ، وبرغم من ذلك ، ما أنَّبه النبي صلى الله عليه وسلم ،
وما سبَّه ، بل وما غضب ، بل كان الرفيق الرحيم ، وقد علَّم أصحابه والأمة
، وهداها بهذا وبقوله : « إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ، ولا ينزع من
شيء إلا شانه » .
وقد قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، حين غضبت من قولة اليهود له
صلى الله عليه وسلم : « السَّامُ عليكم : فقالت : وعليكم السَّامُ
واللعنةُ ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مهلاً يا عائشة
، إن الله يحب الرفق في الأمر كلَّه )) ، فقلت : يا رسول الله ، أولم تسمع
ما قالوا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( قد قلت : وعليكم )) » .
وعن أبي أمامة قال : « إن فتىً شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ائذن لي في الزنا . فأقبل القوم عليه فزجروه ، وقالوا : مَهْ ، مَهْ . فقال : (( ادنه )) ، فدنا منه قريبا ، قال : فجلس ، قال : (( أتحبه لأمك ؟ )) قال : لا ، والله ، جعلني الله فداءك . قال : (( ولا الناس يحبونه لأمهاتهم )) . قال : (( أتحبه لابنتك ؟ )) قال : لا ، والله ، يا رسول الله جعلني الله فداءك . قال : (( ولا الناس يحبونه لبناتهم )) . قال : (( أتحبه لأختك ؟ )) قال : لا ، والله ، جعلني الله فداءاك . قال : (( ولا الناس يحبونه لأخواتهم )) . قال : (( أفتحبه لعمتك ؟ )) قال : لا ، والله ، جعلني الله فداءاك . قال : (( ولا الناس يحبونه لعماتهم )) . قال : (( أفتحبه لخالتك ؟ )) قال : لا، والله ، جعلني الله فداءاك . قال : (( ولا الناس يحبونه لخالاتهم )) . قال : فوضع يده عليه ، وقال : (( اللهم اغفر ذنبه ، وطهَّر قلبه ، وحصَّن فرجه )) فلم يكن بعد ذلك الفتى يلفت إلى شيء » .
أي منكر هذا الذي يستأذن فيه الفتى ؟ وأي منكر يكون ذلك
الاستئذان من سيد الأنبياء ؟ إنه لمنكر جدَّ عظيم ، لا يملك أحد غير النبي
صلى الله عليه وسلم إزاءه ذرة من حلم ورفق ، ولكنه صلى الله عليه وسلم
الرؤوف الرحيم ، الذي بلغ في موقفه هذا وكثير غيره ، حد الإعجاز لكل ما
عداه من الخلق ، أن يبلغ ما بلغ في هذا الحلم والصبر الجميل .
وليس الرفق والحلم في تغيير المنكر ، بذاهب بصاحبه إلى المداهنة والمصانعة
حين يعتدى بذلك عمداً على حق من حقوق الله تعالى ، أو حقوق عباده ، بل
يكون ذلك حينذاك الحزم والحسم والغضبة لله رب العالمين .
(( عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ـ زوج النبي ـ صلى الله عليه
وسلم : « أن قريشاً أهمّهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله
عليه وسلم في غزوة الفتح ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه
وسلم؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أُسامة بن زيد ، حبُّ رسول الله عليه
وسلم ، فكلمه فيها أسامة بن زيد ، فتلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فقال (( أتشفع في حدَّ من حدود الله ؟ )) فقال له أسامة : استغفر
لي يا رسول الله . فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاختطب ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فإنما أهلك
الذين من قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم
الضعيف أقاموا عليه الحدَّ . وإني ـ والذي نفسي بيده ـ لو أن فاطمة بنت
محمد سرقت لقطعت يدها )) ، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت ، فقطعت يدها . »
قال يونس : قال ابن شهاب ، قال عروة : قالت عائشة : (( فحسنت توبتها بعد ،
وتزوجت ، وكانت تأتيني بعد ذلك ، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، متفق عليه ، والنص لمسلم .
كذلك الرفق ، وكذلك الحزم في تغيير المنكر ، كلُُ في موضعه الذي
هو به أليق وأكرم وأجدى وأنفع .
ومما يدخل في باب الرفق والحكمة في هذا ، ألا يكون ذلك مواجهة ومصارحة في
ملأٍ من الناس ، فإنها حينذاك تشهير لا تذكير . يقول الإمام الشافعي : من
وعظ أخاه سرّا فقد نصحه وزانه ، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه .
وقد جعل الله من عقوبة من عَيَّرَه أخاه بذنب ، أن يقع فيه : « من عَيَّرَ
أخاه بذنب لم يَمُتْ حتى يعمله » ، وذلك إذا لم يكن صاحب المنكر مجاهراً
مفتخراً ، به متخذاً فعله رسالة حياته ، كمثل الماسونيين والعلمانيين
والماركسيين وغيرهم من المرجفين المحاربين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
، فمن كان كذلك فقد وجب تغيير منكره ، ودفعه علانية ، وفضح أمره وأفاعيله
وصنائعه السوء والإرجاف وإشاعة الفاحشة والسُّوأى ، فإن الله عز وعلا
حَرَمَ المجاهرين عفوه :
(( عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كُلً
أُمَّتي معافى إلا المجاهرين ، وإنَّ المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا
ثم يصبح وقد ستره الله فيقول : يا فلان ، عملت البارحة كذا ، وكذا ، وقد
بات يستره ربه ، ويصبح يكشف ستر الله عنه » .
فإذا ما كان هذا حال من جاهر على هذا النحو ، فكيف بحال من لا
يفعلها بليل ، بل يفعلها جهاراً نهاراً ، ويتخذها فخاراً ومنهج حياة؟
أولئك أولى بالحرمان من عفو الله ، وأولى بفضح أمرهم للناس ، حتى يعرف
الناس صنيعهم فيحذروا وينكروا .
فالحكمة في تغيير منكر مثل هؤلاء المجاهرين بالمنكر المفاخرين بفعله ،
والدعوة إليه ، الغلظة في وجوههم ، والتصريح بأسمائهم وأوصافهم وأفعالهم ،
وبمن يناصرهم ، أو يسكت عن باطلهم ، حتى يكشف حالهم ، فلا يخدع الناس
بمكرهم ، وزائف فكرهم ، وزخرف قولهم ، وباطل مذهبهم .
وهم ـ خداعاً وزوراً ـ ينعقون في محافلهم العامة ، ومناشيرهم السيارة ،
أنهم مسلمون موحدون ملتزمون بصحيح الإسلام ، وأنِّ من خالفهم إنما هو الذي
يدعو الناس إلى عبادة الله بآراء خلقه ، لا بهدي كتابه ، كذلك يزعمون ،
وينادون أن الإسلام قد عصم دماءهم وأعراضهم وأموالهم ، بلا إله إلا الله ،
وأنهم يقولونها ، فلا تحل دماؤهم وأعراضهم .
ذلك ديدن المنافقين من الماسونيين والعلمانيين والماركسيين ،
فذلك دعامة (( السَّلولية )) التي اتخذوها عقيدة من دون الإسلام . فإذا ما
تخفَّى أولئك تحت ادعاء قول (( لا إله إلا الله )) فإن هذه ليست كلمات
تقال فحسب ، وإلا لما قاتلت (( قريش )) النبي صلى الله عليه وسلم ، حين
طالبهم بها، إنما هي منهاج حياة ورسالة وجود ، لها مقتضياتها وحقوقها ،
وواجباتها . وفي حياة كل قائل لها آيات ظاهرة على تمكنها من قلبه
واستقرارها فيه ، فيكون المسلم المعصوم بها دمه وماله وعرضه ، أو يكون في
حياته ناقضاتُُ لمعنى (( لا إله إلا الله )) ومنهجها ورسالتها ، فتكون تلك
الآيات القاطعات بأنه ليس الذي يعصم بها دمه وماله وعرضه .
كل قائل (( لا إله إلا الله )) عليه أن يعرض نفسه ومنهج حياته وحركته في
الأرض على مقتضيات تمكن (( لا إله إلا الله )) من قلبه أو ناقضاتها .
هل يعصم قول : (( لا إله إلا الله )) من يطعن في كتاب الله ، ومن
يدعو إلى التحرر من سلطة القرآن ، بل من سلطان الله ، ومن لا يرضيه أن
تكون علاقته بالله علاقة عبد بسيده لأنه لا يحب الإذعان ؟ وهل يعصم قول :
(( لا إله إلا الله)) من يستهزئون بالرسول والسنة والصحابة ، كمن يستهزئ
من التيمم بالتراب عند نقض الوضوء لذي عذر ، ويستهزئ بالوضوء بغسل اليدين
والوجه ... إلخ لمن خرج منه ريح ، ويتساءل ما علاقة ذلك بوجهه ويديه ، ألا
يكفي غسل محل خروج الريح ؟
وهل يعصم قول : (( لا إله إلا الله )) ، دم وعرض ومال من يزعم أنَّ بعض
أحكام الشريعة الثابتة بالكتاب والسنة ، إنما هي رجعية وعادات بدوية لا
تليق بالحياة المعاصرة ، وأنَّ القرآن والسنة لا يصلحان في القرن العشرين
أن يحتكم إليهما في حياتنا السياسية والاجتماعية ؟
وهل يعصم قول : (( لا إله إلا الله )) ، دم وعرض ومال من يعلن صراحة أنَّه
ضد الحكم بما أنزل الله ؟
أيتفق ادَّعاء الإسلام ، مع كل هذه الناقضات معنى (( لا إله إلا الله )) ،
من قلوب أصحاب هذه الأقاويل والدعاوى ؟
ويتعلق أولئك المرجفون في المدينة بحديث سيدنا (( أسامة بن زيد
)) الذي رواه الإمام (( مسلم )) الذي يقول فيه سيدنا (( أسامة )) :
« بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبّحنا الحُرُقات من
جهينة، فأدركت رجلا : فقال : لا إله إلا الله ، فطعنته ، فوقع في نفسي من
ذلك ، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: (( أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟ )) . قال : قلت يا رسول ، إنما
قالها خوفا من السلاح . قال : (( أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا
؟ )) . فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ » .
وإذا كان أولئك لا يتعلقون بالسنة إلا حين يرون فيها ما ينفعهم في تنفيذ
مخططهم (( السَّلُولي )) فإن تعلقهم بحديث (( أسامة )) غير نافع لهم .
وكل عاقل يقرأ الحديث قراءة مسلمة ، يجد أن حالهم لا يتفق مع حال الرجل
الذي طعنه (( أسامة )) فقتله .
الرجل الذي قتله (( أسامة )) بعد قول (( لا أله إلا الله )) لم يظهر منه لسيدنا (( أسامة )) بعد قولها ما ينقضها ، من قول أو عمل ، فكان على سيدنا (( أسامة )) أن يعصم دمه بها ، حتى يقع منه ما ينقضها قولاً أو فعلاً ، ولذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : « أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ » ، أي أقالها خوفاً من السلاح ، وما يزال على ما كان عليه قبلها ، أم قالها اعتقاداً جازماً ، فلو أنه بدا من الرجل ما يجعل أسامة يوقن أنه قالها خوفاً ، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قتله بعد قوله : (( لا إله إلا الله )) ، لأنها ستكون مقالة خادعة .
والماسونيون والماركسيون والعلمانيون ، وكل المرجفين في المدينة
، لا يكفون عن قول وفعل ما ينقض قولهم : (( لا إله إلا الله )) نقضا لا
يبقي ولا يذر ، فجميع أحوالهم التي يعيثون بها في الأرض فساداً ، تنادي
صباح مساء أنهم إنما يقولون : (( لا إله إلا الله )) تقية وخديعة ، وأن هم
في هذا كمثل الذين قال الله تعالى فيهم : { وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ
آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا
إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ } ( البقرة : 14 ) .
{ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ
عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } ( آل عمران : 72 ) .
فمثل أولئك ، الحكمة كل الحكمة في تغيير منكرهم ، كشف أقاويلهم
وأفاعيلهم مقرونة بها أسماؤهم وأوصافهم ومواقعهم في الحياة الثقافية
والقيادية ، وبيان أباطيلهم ، وما يرمون به إليه من إفساد في الأرض ، وحب
لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ، حتى يعرف الناس حقيقتهم ، فلا يخدعون
بمعسول قولهم وزخرفهم ، فإن لكثير منهم فصاحة لسان تسبي قلوب وعقول
الدهماء ، وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من أمثالهم .
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «
إن أخوف ما أخاف على أُمتي كلُّ منافق عليمُ اللسان » .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «
من تعلَّم صرف الكلام ليَسْبيَ قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم
القيامة صرفا ولا عدلا » .
وإن من ألزم ما يحمله أهل العلم وطلابه من فرائض ، الوقوف على حقيقة مذاهب
العلمانيين والماسونيين ، والماركسيين ، ومن شايعهم ، والاجتهاد في فحصها
وسبر أغوارها ودفائنها ، وخبئ مراميها ، ونقض ما فيها من دعاوى باطلة
وأقاويل فاسقة .
إن حسن الظن بأمثالهم يردي في مهاويهم ، فالمؤمن كَيِّس فَطِن ، لا يُلدَغ
من جُحْرٍ مرتين .
وإن الحكمة في أمثالهم ، الاستماع إلى قول الشاعر :
والجَهْلُ إنْ تَلْقَهُ بالحلم ضقت به ... ذَرْعا وإنْ تلقَهُ بالجَهْل
يَنْحَسِمِ
بيان المغِّير المنكر : شروطه وآدابه
إذا ما كان تغيير المنكر ، عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى ، فإنه يشترك
مع بقية العبادات في بعض الفرائض :
· أن يكون القائم بالتغيير مكلفا ، وأساس التكليف : العقل والبلوغ ، فمن
جنَّ عقله ، أو أصابه فيه داء ، فقد أعفي من فريضة التغيير ، ما بقي
الجنون أو الداء ، ومن لم يبلغ الحلم ، لا يجب عليه التغيير لمنكر رآه ،
فإن كان مميزاً عارفاً بالمنكر قادراً على تغييره صحَّ له أن يغيره ، ولا
يجوز منعه من ذلك
كما لا يجوز حمله على التغيير ، إلا على سبيل تدريبه على الطاعات من قبل
وجوبها عليه ، على أن يكون ذلك تحت إمرة وليه .
· أن يكون مسلماً ، فإنَّ أي عبادة لا تقبل بغير إسلام ، ولا
تفرض من قبل الدخول فيه ، فلا يتصور أن تفرض على غير المسلم ، أن يغير ما
تنكره شريعة هو لا يؤمن بها ، وإن كان ذلك منكراً في شريعته ، التي يؤمن
بها أيضاً ، فنحن غير مكلفين بحمل غير المسلمين على التمسك بشرائع
عباداتهم ، التي يتفق بعضها مع بعض ما في الإسلام ، فلم يكن النبي صلى
الله عليه وسلم يحمل يهود المدينة على ترك الربا ، وهو المحرم في توراة
موسى عليه السلام ، مثلما هو محرم في الإسلام ، إلا إذا تحاكموا إلى
المسلمين ، فيحملون على حكم الإسلام وحده ، لأنهم تحاكموا إليه طواعية .
فإذا أعان غير المسلم على تغيير المنكر ، أثيب على إعانته تلك ، بما يليق
بها من نعم الدنيا ، ولا يصح منعه من أن يعين على ذلك إلا إذا خرق شروط
التغيير وآدابه .
· ولا يشترط مع الإسلام العدالة ، فكل مسلم يجب عليه تغيير
المنكر على الوجه الذي هو أهل له ، وليس بلازم أن يكون غير مرتكب للمنكرات
. ذلك ما عليه أهل العلم فإن للفاسق بل عليه أن يغير المنكر ، إلا إذا كان
لا يقيم الصلوات المكتوبات استهانة أو استهزاء أو إنكاراً لفرضيتها ، فإنه
يكون بذلك غير مسلم البتة ، بل هو مرتد ، وهو أدنى منزلة من أهل الكتاب ،
فإن استتيب وتاب والتزم ، وجبت إعانته وإكرامه وتأليف قلبه .
أما إن كان فاسقاً يؤدي الصلاة أو يتركها كسلاً لا استهانة ـ عند بعض أهل
العلم ـ فإنه لا يُسقط عنه فريضة تغيير المنكر بسقوطه هو فيه ، فإن الفسق
لا يرفع التكليف ، مثلما ترفعه الردّة ، وهذا الفاسق يكون على أحد أمرين :
- أن يكو مرتكبا منكرا غير الذي يراه من غيره .
- أن يكون مرتكباً منكراً من جنس ما يراه من غيره .
إن كان الأول ، فإن تغيير منكر غيره فرض عليه ، ما تحققت فيه
بقية شرائط التغيير . فلا يتأثر بوقوعه هو في منكر آخر ، فالواقع في منكر
الغيبة مثلاً ، عليه أن يغير منكر سرقة واقع من غيره . فإِننا لو اشترطنا
أن يكون القائم بالتغيير خالياً من كل منكر ، فإنا نكاد لا نجد من يتحقق
في ذلك ، ولا سيما في عصرنا والعصور القادمة .
يقول سعيد بن جبير : (( إن لم يأمر بمعروف ولم ينه عن المنكر ، إلا من لا
يكون فيه شيء ، لم يأمر أحد بشيء )) فأعجب مالكا ذلك من سعيد بن جبير )) .
وإن كان الآخر أي المغيِّر ، واقعاً في منكر من جنس ما يراه من غيره ، فإن
له حالين : أن يكون غيره عليماً بوقوعه فيه أو لا يكون .
إن كان عليماً بوقوعه فيه فالأولى تغيير منكر نفسه أولاً ، ولا سيما إذا
ما كان التغيير باللسان ، حتى لا يكون السعي إلى التغيير حينئذٍ عقيماً أو
عقباه أكثر ضرراً .
وإن كان غير عليم بوقوعه فيه ، لم يتوقف تغييره منكر غيره على تقديم
تغييره منكر نفسه ، بل يفعلهما معاً أيَّاً كان سبيل التغيير وآلته ، فلا
ينتظر الفراغ من تمام تغيير منكر نفسه ، ولا سيما إذا ما كان المغير ذا
ولاية عامة أو خاصة على من يريد تغيير منكره .
فإن كان من العامة ومن حوله من يمكن أن يقوم بالتغيير دونه ،
فعليه الاشتغال بتغيير منكر نفسه أولاً ، ويدع غيره يقوم بتغيير هذا
المنكر متى كانوا قادرين وصالحين لتغييره .
(( يروى أن رجلاً جاء سيدنا عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فقال يا
ابن عباس ، إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال : أبلغت ذلك ،
قال : أرجو ، قال : إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله ، فافعل .
قال : وما هنَّ ؟
قال : قوله تعالى : { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
أَنْفُسَكُمْ } ، أحكمت هذه ؟ قال لا .
قال : فالحرف الثاني ؟ قال : قوله تعالى : { لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا
تَفْعَلُونَ } ، أحكمت هذه ؟ قال : لا ، فالحرف الثالث ؟
قال : قولُ العبد الصالح (( شعيب )) عليه السلام : { وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا
الْإِصْلَاحَ } ، أحكمت هذه ؟ قال : لا . قال : فابدأ بنفسك )) .
في هذا الموقوف على (( ابن عباس )) إن صح سنداً ، دلالة على أنَّ
المرء أن يكون أهلاً للقيام بفريضة الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ،
حتى يكون قياماً مثمراً ، فإن لم يك أهلاً فعليه أن يبدأ بنفسه ، ويدع
غيره لمن هو قادر علي هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فيؤديهما
أداء غير عقيم .
على أنه ينبغي أن نكون على وعي ، بأنَّ ما قاله ابن عباس لهذا الرجل إنما
هو مخصوص بحال ما إذا كان مِنْ حول الرجل مَنْ هو أقدر على القيام بفريضة
الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، فيترك ذلك لمن هو أقدر على نحو ما
كان في زمان (( ابن عباس )) ، إذ كان جمهور الصحابة والتابعين كثير .
أما إن كان مثل ذلك الرجل في مجتمع ليس فيه من هو أقدر منه على ذلك أو كان
فيه ، ولكن عجز عن الوفاء بكل الفريضة ، أو شغله المال والأهلون ، فلا ريب
في أن مثل هذا الرجل ، وإن لم تتحقق فيه الآيات الثلاث المذكورات ، يجب
عليه القيام بفريضة التغيير لمنكر غيره ، في الوقت الذي يسعى فيه جاهداً
الىتحقيق هذه الآيات الثلاث على الوجه القويم .
ومما ينبغي وعيه هنا أن الرجل كان يرمي إلى الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ، وليس إلى تغيير منكر يراه ، وفرقُُ غير خفي بين فريضة
تغيير منكر وقع ورآه المرء ، وفريضة أمر بمعروف ونهي عن منكر ، وإن لم يقع
.. فالتغيير ، بعض النهي ، وليس كله .
على أن قوله تعالى : { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ } ... الآية وقوله تعالى :
{ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ } لا يؤخذ منه أن مرتكب المنكر لا
يغير منكر غيره ، فقد جاء هذا القول في سياق ذم النهي عن المنكر وإتيانه ،
أو الأمر بالبر ، وترك فعله في الوقت نفسه ، ولا يلزم من ذلك منع النهي عن
المنكر ممن هذه حاله ، أو منع الأمر بالبر ممن هذه حاله ، بل هو دعوةِ إلى
ترك المنكر ، لا ترك تغييره في غيره ، حتى يتركه هو .. فهو قول سيق للنهي
عن ارتكاب هذه الأفعال ، وإبراز شناعة إتيانها مع العلم بأنها منكر ، ومع
دعوة الآخرين إلى تركها .
ومثل هذا أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : « يؤتى بالرجل يوم
القيامة فيلقى في النار فتندلقُ أقتابُ بطنه ، فيدور كما يدور الحمار
بالرحى ، فيجتمع إليه أهل النار ، فيقولون : يا فلان ، ما لك ؟ ألم تكن
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول : بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا
آتيه ، وأنهى عن المنكر وآتيه » ( متفق عليه ، والنص لمسلم ) .
فذلك الحديث غير مسوقٍ إلى النهي ، عن القيام بالأمر بالمعروف ، والنهي عن
المنكر ، ممن لم يفعل المعروف ، ويمتنع عن المنكر ، بل هو مسوق إلى
الإبلاغ في بيان شناعة إتيان المنكر مع النهي عنه ، وترك المعروف وأمر
الآخرين به .
يقول الغزالي في قوله تعالى : { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ }
ونحوه : (( هو إنكارُُ عليهم من حيث تركهم المعروف ، لا من حيث أمرهم ،
ولكنَّ أمرهم دلَّ على قوة علمهم ، وعقاب العالم أشد ، لأنه لا عذر له مع
قوة علمه )) .
· ويبقى شرط إذن الولي الأعلى ، أو من ينيبه ، لمن يقوم بتغيير المنكر :
يذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط إذن ولي الأمر الأعلى ، لمن يقوم
بالتغيير ، ويذهب آخرون إلى عدم اشتراطه .
وتحقيق ذلك متوقف على أشياء ثلاثة : حال ولي الأمر ، وحال
المغيرِ ، وحال وسيلة التغيير ، والكيفية التي يتم بها التغيير .
أمَّا حال ولي الأمر ، فإما أن يكون حاكماً بما أنزل الله تعالى ، وإما أن
يكون غير ذلك :
إن كان مقيماً لشرع الله تعالى ، لا يحكم بغيره عمداً ، ولا يخلط به غيره
، فإن كان المغيِر من العامة ، فإن تغيير المنكر في نفسه ، ومن له عليهم
ولاية خاصة كالأهل ، لا يحتاج إلى إذن ، إذا ما غير بلسانه أو بيده في بعض
صور التغيير باليد ، وإن تكن بعض صور التغيير باليد حينئذ تحتاج إلى إذن ،
كأن يترتب على التغيير باليد إيذاء بالغ في نفس مرتكب المنكر كأن يضربه
ضرباً مهلكاً أو مبرحاً
أما ما رُوي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ « أنَّ أعمى كانت له أُم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه ، فينهاها فلا تنتهي ، ويزجرها فلا تنزجر . قال : فلما كانت ذات ليلة ، جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه ، فأخذ المِغْوَلَ فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها ، فوقع بين رجليها طفل ، فلطخت ما هناك بالدم ، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فجمع الناس فقال : (( أنشد الله رجلا فعل ما فعل ، لي عليه حق إلا قام )) ، قال : فقام الأعمى يتخطى الناس ، وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أنا صاحبها ، كانت تشتمك ، وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي ، وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ، وكانت لي رفيقة ، فلما كان البارحة ، جعلت تشتمك وتقع فيك ، فأخذت المغول ، فوضعته في بطنها ، واتكأت عليها حتى قتلتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ألا اشهدوا أنَّ دمها هدر )) » .
إن المنكر الذي وقعت فيه هذه المرأة ، إنما هو كفر صراح ، وقد
زجرت عنه مرارا ، ومثل هذا يستباح به الدم ، فإن شتم النبي صلى الله عليه
وسلم ، والجهر بذلك ، والإصرار عليه ، بعد الزجر ، مما لا تحتمله نفس من
في قلبه ذرة من إيمان ، وكذلك الاستهزاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله
عليه وسلم ، والجهر بذلك ، والإصرار عليه .
والصحابي قد أعلن بقوله : ( ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ، وكانت لي
رفيقة ) أنه ما قتلها لأمر به متعلق ، وإنما احتسابا لوجه الله ، وغضبة
لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
أما إن كان المنكر في غير أهله، وفي من ليس له عليهم ولاية خاصة ، فإن تغيير المنكر باليد ، يحتاج إلى إذن ولي الأمر المقيم شرع الله تعالى ، وتغييره باللسان إن كان أهلاً له لا يحتاج وله أن يتركه لمن هو أعلم به منه ، إن علم أنَّ غيره هذا قائم بذلك ، والأولى السعي إلى من يظن أنه أعلم ، وأقدر ، وأولى ، فيخبره ليغير ما رآه من منكر ، إن كان ذلك المنكر ، مما يحتمل تأخير تغييره قليلاً ، فيكون بسعيه إلى من هو أقدر وأعلم بالتغيير قائماً بتغيير المنكر أيضاَ ، ويبقى من بعد ذلك عليه مؤازرة أهل العلم والاحتساب ، وتكثير سوادهم ، وحمايتهم ، والدفع عنهم ورعايتهم في أهلهم ، إن أضيروا ، والدعاء لهم .. فكل ذلك من صور التغيير .
أما إن كان المغيِّر من أهل العلم ، والإمامة ، المشهود لهم في
هذا من الصالحين ، وكان ولي الأمر الأعلى مقيماً شرع الله تعالى ، فإنَّ
تغييره المنكر في غير أهله بيده يحتاج إلى إذن من ولي الأمر ، إذا ما كان
هذا التغيير مرتباً عليه إيذاء في نفس صاحب المنكر ، أما إن كان الضرر
واقعاً على ما هو خارج عن نفسه فللعالم الثقة أن يغير المنكر في غيره أهله
، دون إذن خاص من ولي الأمر ، لأن ولي الأمر المقيم شرع الله تعالى ، يأذن
ضمناً للعالم الثقة ، أن يغير المنكر بيده فيما لا يتعلق بالأنفس ، وكذلك
تغييره المنكر بلسانه ، لا يحتاج فيه العالم من ولي الأمر ، المقيم شرع
الله ، إذناً خاصاً ، لأن علمه وإمامته والشهادة له بذلك من أقرانه من أهل
العلم ، إذنُُ عامُُ ، بأن يغير المنكر بلسانه ، بل هو أول من يفرض عليه
ذلك التغيير ، وليس لأحد أن يمنعه من ذلك ، متى حقق آداب التغيير باللسان.
أما تغييره بالقلب ، فذلك ما لا يستأذن فيه أحدُُ من أحد أبداً ، فهو
فريضة لا تسقط إلا بسقوط التكليف .
وإن كان ولي الأمر الأعلى لا يحكم بشرع الله تعالى ، أو يخلط به
ما يشرعه لنفسه ، فيأخذ ببعض الشرع في أبواب ، ويتركه في أبواب أخرى ، فإن
الأمر يختلف :
إن كان المُغَيِّرُ من العامة ، فله أن يغير المنكر بلسانه ، حين يكون
قادراً عليه سواء كان المنكر واقعاً من أهله ، ومن له عليهم ولاية ، أم من
غيرهم ، شريطة الالتزام بآداب التغيير باللسان .
ولا يحتاج إلى إذن ولي الأمر ، الذي لا يقيم شرع الله تعالى ، فإن منعه
امتنع متى كان في الأمة من يقوم به سواه . ويبقى عليه مؤازرة أهل العلم في
هذا ومناصرتهم ، والدعاء بنصر الحق وأهله .
وله أن يغير المنكر بيده حين يكون قادراً عليه ملتزماً بشروطه وآدابه ،
فيما لا يتعلق بالأنفس . والأعلى والأحب إلينا ، أن يكون ذلك منه في صحبة
مغير من أهل العلم . أو يسعى إلى من هو أقدر وأولى فيخبره ، ويؤازره ،
ويشد من عضده ، لتكون لأهل العلم المحققين شوكة في وجه ولي الأمر ، الذي
لا يقيم شرع الله تعالى ، فإنه إذا رأى لهم شوكة ، خضع للحق ، الذي يدعون
إليه .
وإن كان المغير من أهل العلم المشهود له به فإن تغيير المنكر
بلسانه لا يحتاج إلى إذن من ولي الأمر الذي لا يقيم شرع الله تعالى ، وإن
منعه ولي الأمر فله ألا يمتنع ، بل يصابر ويجالد ، لأنَّ هذا حق الله عز
وجل كلَّف به أهل العلم وليس لولي الأمر ، أن يمنعهم من أداء حق الله
تعالى : « إنما الطَّاعة في معروف » .
وما يفعله بعض الولاة من إيجاب استئذان العالم في الدعوة إلى الله في بيوت
الله ، إنما هو بغي وعدوان على حق أهل العلم، فإنَّ من تحققت فيه آيات
العلم والصدق ، كان في تكليف الله له بالبيان ، إذناً إلهياً ، لا يصادره
أحد متى التزم بأدب الدعوة إلى الله تعالى وقال كلمة الحق احتساباً .
أما تغيير العالم المنكر بيده ، فيما لا يتعلق بالأنفس ، فلا يحتاج إلى
إذن من ولي الأمر ، الذي لا يقيم شرع الله ، لأنه بالضرورة لن يأذن لأحد ،
وهو حين أعرض عن شرع الله تعالى ، فلم يحكم به رعيته ، قد أسقط حقَّ نفسه
عليهم في طاعتهم له . فللعالم تغيير المنكر بيده ، فيما دون الأنفس ، دون
إذن هذا الولي إذا ما حقق آداب وشروط التغيير باليد.
وللعالم أيضاً أن يأمر غيره ممن هو قادر عليه ، أن يغير المنكر بيده ، تحت
رايته
وعلى العامة مناصرة العلماء في هذا والوقوف معهم والدفع عنهم ،
والدعاء لهم.
وكل ما قلناه في تغيير المنكر باليد ، إنما هو حين يعلم به ولي الأمر ، أو
من ينوب عنه ، ثمَّ لا يقوم بالتغيير ، أو لا يأمر أحداً بتغييره من ولاته
، فإن كان ممن يقوم هو بتغييره أو يأمر من يغيره إذا ما بلغه ذلك ، وتحقق
منه فليس لأحد أن يتجاوز إذنه في تغيير المنكر باليد ، لأن ذلك حق ولي
الأمر، لا يسقط منه ولا يتجاوز إذنه ، إلا إذا تركه وأسقطه بالتغافل عنه
أو الزعم بأن هذا من الحرية الشخصية ، التي لا يسمح لنفسه الاعتداء عليها
. في الوقت الذي يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا مسَّه أحد بما يكره ، من قول
أو فعل . وصدق الشاعر قائلاً :
يقاد للسجن من سَبَّ الزعيم ومن ... سَب الإله فإن الناس أحرارا
· ويشترط في المغير شروط أخرى ، منها ما سبقت الإشارة إليه تحقق العلم
بنكارة ما يريد إنكاره ، عند جمهور العلماء ، فإن لم يتحقق ، وعلم أنَّ
فيه اختلافاً ، ممن يوثق باختلافهم ، ويعتد به ، فإنه لا يجب عليه التغيير
، بل يكتفي بالدعوة إلى ما هو الأسمى والأرجح ، مبيناً لمن شاء وجه رجحان
ما يدعو إليه .
ويشترط فيه العلم بطرائق التغيير ، وأحكامها ، وآدابها ، ومن جهل
شيئاً من هذا وجب عليه أن يسعى إلى من يعلمه ، ثم يقوم بالتغيير ، ولا
يستكين إلى أنه لا يعلم ، فعليه أن يغير جهله بذلك ، إلى العلم به ، متى
كان في قومه من يعلمه ، وقد تيسر العلم في زماننا لمن شاء .
ويشترط في المغير أيضاً ، أن يكون قادراً على التغيير ، فإن عجز عن طريق ،
انتقل إلى ما دونه وسعى إلى أن يرفع عن نفسه أسباب عجزه ، عن القيام
بالطريق الأعلى . فإن المسلم لا يليق به أن يرضى بالدنية ، فيما يتعلق
بشؤون دينه وآخرته ، وليكن حرصه على الأعلى في هذا ، لا يقل عن حرصه عليه
في شؤون دنياه .
ولا يشترط في المغير أن يتيقن أن تغييره المنكر مفض إلى أثر ، فيمن يغير
منكره ، فليس عليه أن ينظر تقبل وعظه ، أو الاستجابة لأمره ونهيه ، فإن
الله عز وعلا ما كلفنا أن يكون لدعوتنا أثر في الآخرين : { فَإِنْ
أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا
الْبَلَاغُ } ( الشورى : 48 ) .
وقد كان النبي في الأمم الغابرة ، يقيم في قومه ، فلا يستجيبُ له إلا قليل ، أولا يستجيب له أحد . (( عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عُرضت عليَّ الأمم ، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط ، والنبي ليس معه أحد » .
بيان الواقع في المنكر : شروطه وأحواله
لما كان التغيير ، إنما هو واقع على منكر محقق ، يقوم به واحد من الناس ،
فإنَّ ذلك الواقع في هذا المنكر لا يشترط لتغييره أن يكون مكلفاً ( عاقلاً
، بالغاً ) ، بل كل منكر يقع من أحد ، يكون ذلك الفعل منكراً في حقه ، أو
حق من هو مثله ممن ليس له فيه رخصة ، فإنه يجب تغييره.
المجنون يمنع من إتلاف ماله ، أو مال غيره ، وكذلك الصبي ، وإن كان كلاهما
غير مكلف .
والكافر البالغ العاقل ، يرجع تغيير منكره الواقع منه ، إلى نوع ذلك
المنكر ومحله.
إن كان منكره مما ليس منكراً في دينه ، ولا يتعلق به حق مسلم ، فلا يجب
على أحد تغيير هذا المنكر ، لأن كفره هو نفسه أعلى المنكرات ، ولا يجب على
أحد أن يمنعه منه ، بل ولا يصلح لأحد أن يكرهه على تركه .
وإن كان منكره مما هو منكر في دينه ـ أيضاً ـ وإن تعلق به حق غير مسلم فلا
يجب على أحد أن يغيره ، إلا إذا تحاكم إلينا ، فيحمل على ما يحكم به
الإسلام الذي احتكم إليه .
فإن تعلق بحق مسلم ، وجب منعه منه ، وإنزاله على ما يقضي به الإسلام ،
حفاظاً على حق المسلم ، أو حق الأمة والدعوة .
وإن كان صاحب المنكر مسلماً مكلفاً ، فيشترط فيه التيقن أنَّ ذلك
الفعل منكر في حقه عند جمهور أهل العلم ، فإن كان فيه خلاف ، وهو على ما
كان مرجوحاً ، فلا يجب على أحد تغييره ، بل ينصح إلى الأعلى بالحكمة .
والمسائل في هذا الباب كثيرة ، مما يستوجب على القائم لتغيير منكر ما ، أن
يعلم موقعه من باب ما اختلف الأئمة في حكمه .
وقد يكون ما فعل منكراً في نفسه عند جميع العلماء ، إلا أنه في حقه خاصة
ليس منكراً ، لوجود رخصة له ، ترفع عنه نكارة هذا الفعل ، كمن أفطر في
رمضان لعذر ، أو غطى رأسه في الطواف لعذر ... إلخ .
فإن كان فعله ما حَرُم ، لضرورة شرعية ، فإنه يُسعى إلى رفع الضرورة عنه
لا أن يمنع من ذلك المحرم ، فإن أزيلت أسباب الضرورة ، وبقي على منكره
غُيّر عليه بالسُبل التي حددها الإسلام .. فكان فقه حال ذي المنكر ، من
ركائز شخصية المغيِر ، وركناً ركيناً من مسؤوليته .
تابع الفصل الثاني
بيان وسائل التغيير : مراتبها وآدابها
تغيير المنكر باليد : أحواله وآدابه
تغيير المنكر باللسان : أحواله وآدابه
تغيير المنكر بالقلب : أحواله وآدابه
العجز عن التغيير باليد أو اللسان
بيان وسائل التغيير : مراتبها وآدابها
الناظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنه حين أوجب على من رأى
منكراً أن يغيره ، ذكر وسائل التغيير ومسالكه ، وقد أحاط بها جامعة . ذلك
أنَّ ما يقع من عمل الإنسان ، نوعان كُليَّان :
- داخل جوَّاني قلبي .
- خارجي برَّاني.
وهذا الثاني ( الخارجي ) قسمان : فعل وقول ، القول : أداته اللسان وما
ضارعه من أدوات البيان . والفعل : أداته الجارحة كاليد وما ضاهاها مما
يستخدمه الإنسان في أفعاله .
فالتغيير إما جواني قلبي ، يترتب عليه واقع سلوكي في الحياة ، وإما خارجي فعلي أداته اليد وما ضاهاها ، وإما خارجي قولي أداته اللسان وما ضارعه ، فكان فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم جمعاً محكماً . وهو قد رتبها على نحو جامع بين النهج الصاعد من وجه ، والنازل من آخر : الوجه النازل ( اليد ـ اللسان ـ القلب ) ناظرُُ إلى الاستطاعة ، وإلى حال المغيِّر ، ومنزلته في القيام بفريضة التغيير ، فإن المغير باليد لا شك أعلى قدرة واستطاعة ، فالتغيير باليد أحوج إلى مزيد من الشجاعة والمصابرة والحكمة والحزم ، ثم من بعده في هذا ، التغيير باللسان ، ثم من دونهم جميعاً في هذا المغير بالقلب فكان البدء بالأصعب أداء ، والأشق تكليفاً ( التغيير باليد ) ، وهو في الوقت نفسه أعلى منزلة ، وأنفذ أثراً ، وأسرع ، وأنجع علاجاً .
والوجه الصاعد في الترتيب نفسه ( اليد ـ اللسان ـ القلب ) ناظرُُ
إلى شمولية التكليف ، وكثرة من يطيق أو من يصلح ، فلا شك في أن التغيير
باليد وما ضارعها ، من يكلف به لتحقق شروطه فيه ، أقل بكثير ممن يكلف
بالتغيير باللسان ، وكذلك من يطيق أو من يصلح للتغيير باليد ، أقل ممن
يطيق أو يصلح للتغيير باللسان ، وأكثر ذلك عدداً في هذا التغيير بالقلب ،
فذلك الذي لا يعجز عنه مسلم البتة ، فكل المسلمين له صالحون ما داموا
أهلاً للتكليف .
فالترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ناظر في حاليه ، إلى منهاجية
التدرج العلمي للتغيير ، وليس ناظراً إلى التدرج التربوي للنهي عن المنكر
، وفرق بين تغيير المنكر والنهي عنه ، فالتغيير أخص من النهي .
ومنهاجية التدرج في النهي ، يُبْدأ فيها بالتعليم ، وتأليف القلوب ،
واستمالتها إلى البعد عن المنكر بالحكمة والموعظة ، فإن لم يُجد ذلك انتقل
إلى ما هو أشد منه في النهي ، كإظهار التجهم والإعراض عن الإكرام ، فإن لم
يجد ، كان النهي بما هو أشد من ذلك .
هذه مراحل تربوية في النهي عن المنكر ، أما تغيير المنكر فإن
المنهج يبدأ بما هو أشد تكليفاً ، يبدأ المرء بالمنع باليد ، فإن عجز عنه
كان باللسان ، فإن عجز عنه كان بالقلب ، فهو تدرج ناظر إلى درجات التكليف
ومراحله ، وإلى مقدار استطاعة فاعله ، وليس إلى قابلية التأثير في المنهي
عن المنكر .
ولما كان نظرنا إلى تغيير المنكر ، فإنا نعتمد التدرج المنوط باستطاعة
المغير لا التدرج المنوط بقابلية القائم بالمنكر ، أو الواقع فيه للتأثير .
تغيير المنكر باليد : أحواله وآدابه
هذا التغيير غير مقصورٍ على طائفة من الناس ، يكون لها أو عليها دون غيرها
، بل هو عام يختلف مناطه ودرجته باختلاف أمور عدة أهمها :
- علاقة من يقوم بالتغيير ، بمن يقع منه المنكر .
- نوع المنكر المراد تغييره ومناخات وقوعه .
وبيان هذا : أن علاقة المغيِّر ، بمن وقع منه المنكر على واحد من خمسة
أحوال :
1- أن يكون للمغيِّر ولاية خاصة على ذي المنكر ، كولاية الوالد على ولده ،
والزوج على زوجته .
2- أن يكون للمغيِّر ولاية عامة على ذي المنكر ، كولاية السلطان على رعيته
وأمته .
3- إلا يكون لأي من المغيِر وذي المنكر ولاية عامة أو خاصة ، كما بين
أفراد الرعية .
4- أن يكون لذي المنكر ولاية خاصة على من يقوم بالتغيير ، كأن يكون ذو
المنكر والد المغير ، أو زوجها .
5- أن يكون لذي المنكر ولاية عامة على المغيِر ، كولاية السلطان الواقع في
المنكر على رعيته التي تريد تغيير منكره .
هذه خمسة أحوال يختلف حكم التغيير باليد باختلافها ، وباختلاف المنكر .
نفسه وظروفه . على أن التغيير باليد غير محصور في القوة ، التي
هي استخدام السيف ، وما شاكله ، أو الضرب وما ضارعه ، فإن التغيير باليد
ذو صور ومراحل عديدة .
من ذلك استخدام اليد في إفساد آلات المنكر ، أو إذهاب عين المنكر ، كتحطيم
أدوات شرب الخمر وإراقتها ، وتهديم حاناتها ، إذا لم تكن تصلح إلا لذلك ،
أو غلق الطرق المؤدية إليها ، أو قطع المياه وأدوات الإنارة عنها ، وكذلك
إفساد آلات الغناء الماجن المحرم ، وأدوات تصوير المنكر أو طبعه أو نشره
في الناس ، وإفساد أماكن بيعه وتوزيعه ، إذا لم تكن تلك الأماكن صالحة إلا
لذلك .. إلخ.
كل هذا وكثير مثله يدخل في التغيير باليد ، وهو ليس من استخدام السيف
المؤدي إلى إراقة دم ، أو إزهاق روح .
· الحالة الأولى : أن يكو للمغيِر ولاية خاصة على ذي المنكر ، كولاية
الوالد على ولده ، والزوج على زوجته.
أساس الحكم في هذا ، قوله صلى الله عليه وسلم : « كُلكم راعٍ وكلكم مسؤول
عن رعيته : الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته ، والرجل راعٍ في أهله ، وهو
مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ، والخادم
راعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته .
قال : حسبت أن قد قال : والرجل راعٍ في ماله أبيه ، ومسؤول عن
رعيته وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته » ( متفق عليه ، والنص لمسلم ) .
فعلى الوالد والزوج وما ضارعهما تغيير المنكر الواقع ، ممن هو تحت
ولايتهما بيده ، وفقاً لما يتناسب مع هذا المنكر ، من صور التغيير باليد ،
فقد يكفي في تغييره إفساد آلته دون اللجوء إلى ما هو فوق ذلك ، فكل صورة
من صور التغيير تقوم بحق التغيير لا ينتقل إلى ما فوقها .
والوالد والزوج وما ضارعهما ، له حق التغيير بكل صور التغيير باليد ، دون
الحدود ، أو ما فيه إزهاق روح ، أو إراقة دم ، فذلك للإمام بحقه الذي شرعه
الله عز وعلا .
· الحالة الثانية : أن يكون للمغيِّر ولاية عامة على ذي المنكر ،
كولاية السلطان على رعيته ، فإن لهذا المغير ، أو عليه تغيير منكر رعيته
باليد ، بكل صور التغيير باليد ، تغييراً لا يبقي منه ولا يذر ، فيكسر
آلات المنكر ، أو يزيل عينه أو ما يقوم به ، ويتخذ كل ما يحقق له القيام
بهذا الغرض قياماً خالصاً تاماً لله ، وليس انتصاراً لسلطانه فإن قاومه ذو
المنكر وأعوانه ، أخذ على يديهم بما يتناسب مع مقاومتهم ، وما يبديها ،
ولو أدى إلى قتل من قاوم ، إن لم يكن من القتل بدَّ .
العجز عن تغيير المنكر باليد ، إذا كان لا بد منه ، لا يتأتى مع حال ولي
الأمر ، إن كان صادقاً مع الله تعالى .
ولا يدخل في هذا التغيير باليد العلماء ، الذين لم تكن لهم نيابة من
الوالي ، إذا كان الوالي مقيماً شرع الله تعالى ، فولاية العالم في رعاية
الوالي المسلم ، إنما هي ولاية تعليم ، ونصح ، وفتوى ، وليست ولاية تنفيذ .
أما إن كان الولي الأعلى لا يقيم شرع في حكمه ، ويأبى تغيير
المنكر ، أو يقر أهله عليه ، أو يزعم أن ذلك من الحقوق الشخصية المكفولة
لهم ، بما شرعه هو أو بطانته ، أو بما نص عليه ، ما يسمى بحقوق الإنسان
العالمية ، أو كان لا يعترف بأنَّ هذا منكر يجب تغييره ، من بعد أن بينَّه
له العلماء بياناً شافياً ، لا يتوقف معه من كان غير ذي هوى ، فإنَّ
للعلماء بل عليهم فريضة أن يتحدوا وأن يغيروا المنكر ، بأيديهم ، دون
البلوغ به حد إزهاق روح ، أو إراقة دم ، فإن خافوا فتنة بهذا أضر بالأمة
من هذا المنكر ، فإنهم أهل الحكمة ، يقدرون الأمور بمقاديرها ، ويقدمون
الأهم على غيره .
وقد كان (( ابن تيمية )) يغير المنكر ، هو وأعوانه بيديه ـ كما يحكي ((
ابن كثير )) في أحداث عام (669هـ ) ـ فقد كسر آنية الخمر في الحانات ،
ومزق أوعيتها ، وأوراقها ، وفرح الناس بذلك .
ولولا أن السلطان في عصره ، لم يكن يقيم الشرع ، ويغير المنكر ، ما كان
لابن تيمية الفقيه أن يعتدي على حقه ، وهو العليم بذلك الحق .
فلإمام العلماء في مثل هذا ، أن يقيم تغيير المنكر ، حين يتخلى
الوالي عن حقه ، ويهدر حق الشرع . وليس للعامة أن تفعل ذلك ، إلا بمعونة
العلماء وفتواهم ، وتحت إرادتهم الراشدة الحكيمة .
· الحالة الثالثة : إلا يكون لأي من المغَيِر ، وذي المنكر ولاية عامة أو
خاصة على الآخر ، كما بين أفراد الرعية .
هذه الحالة ذات شقين :
- أن يكون ولي الأمر الأعلى يقيم شرع الله وينكر المنكر ويغيره حين يعلم
به .
- ألا يكون كذلك .
إن كان يقيم الشرع ، ويغير المنكر ، فليس للعامة أن تغير المنكر الواقع ،
ممن ليس لهم عليه ولاية ، تغييراً باليد ، بل عليهم إبلاغ ولي الأمر ، أو
نوابه ، ومن أقامهم لذلك ، وهم يتولون ذلك ، فإن طلبوا معاونة العامة ،
فقد وجب عليهم تقديم العون لهم وفق مطلوبهم وتحت إمارتهم .
وأما إن كان الولي لا يقيم شرع الله ولا يغير المنكر ، بل يجعله
من الحقوق المكفولة ، بما شرعه هو أو بطانته من قوانين ، فعلى العامة
اللجوء إلى أئمة العلماء ، ورفع الأمر إليهم للتصدي للسلطان ، وحمله على
تغيير المنكر ، وإلا قاموا هم به ، وعلى العامة حينذاك مناصرة العلماء ،
وتأييدهم وحمايتهم ، فإن العلماء إذا ما وجدوا عوناً من العامة ، قاموا في
وجه السلطان ، الذي لا يقيم شرع الله تعالى بما يحمله على العدل ..
والسلطان إذا ما علم أن الأمة من خلف علمائها خضع للحق الذي يدعو إليه
العلماء ، وتريده العامة ، فإنَّ السلطان الطاغية لا يشتهي شيئاً كمثل
اشتهاء إهانة العلماء وإذلالهم ، وتحطيم منزلتهم في قلوب العامة .
· الحالة الرابعة : أن يكون لذي المنكر ولاية خاصة على من يقوم بتغيير
منكره ، كأن يكون ذو المنكر والد المغيِّر أو زوجها ، فإن كان كذلك فتغيير
المنكر باليد حينئذ يرجع إلى نوع المنكر ودرجته ، فثَمَّ منكر يغير باليد
، دون أن يلحق صاحب المنكر إيذاء في نفسه ، فللولد ، والزوجة في مثل هذا ،
تغيير المنكر باليد ، إذا لم يترتب على ذلك ما هو أشدَّ ضرراً .
وللولد أن يمنع أباه والزوجة زوجها من الإقدام على ما يتعلق به
حق الآخرين ، كمثل قتل أو سرقة أو إحراق مال ... فذلك مما لا يحتمل
تأخيراً في تغييره بالصد عنه .
فإن كان المنكر كفراً بواحاً فليرفعه إلى السلطان المقيم شرع الله تعالى ،
ليغيره بما يستحق.
فتغيير المنكر باليد ممن هو تحت ولاية ذي المنكر ، إنما يجب عليه حين لا
يكون غيره أهلاً للقيام به أو كانت الملابسات لا تسمح باللجوء إلى آخرين
للقيام بذلك . فإن كان فيمن حولهم ، من يكون أهلاً للقيام بذلك حق قيامه ،
فالأولى أن يلجأ الولد إليهم لتغيير منكر والده بما يستحق ، وكذلك الزوجة .
ويذهب الإمام الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ إلى أن للولد مع والده
الواقع في المنكر ، أن يغيره بالمنع ، بالقهر ، بطريق المباشرة ، (( بأن
يكسر مثلاً عوده ، ويريق خمره ، ويحل الخيوط من ثيابه المنسوجة من الحرير
، ويرد إلى الملاك ، ما يجده في بيته من المال الحرام الذي غصبه أو سرقه ،
أو أخذه عن إدرار رزق من ضريبة المسلمين إذا كان صاحبه معيَّناً ، ويبطل
الصور المنقوشة على حيطانه ، والمنقورة في خشب بيته ، ويكسر أوان الذهب
والفضة ، فإنَّ فعله في هذه الأمور ليس يتعلق بذات الأب ، بخلاف الضرب
والسب ، ولكن الوالد يتأذى به ويسخط بسببه إلا أنَّ فعل الولد حق وسخط
الأب منشؤه حبه للباطل وللحرام ، والأظهر في القياس أنه يثبت للولد ذلك بل
يلزمه أن يفعل ذلك )) .
وما نقوله إنما هو في حال ارتكاب المنكر ، أو الإعداد له ، أما إذا كان
المنكر قد وقع فإن أمر صاحبه يرفع إلى السلطان ، ليقضي فيه بالحق ، وهذا
أصل في جميع الأحوال ، إن المنع حق عام ولكن العقوبة حق السلطان .
· الحالة الخامسة : أن يكون ذو المنكر ذا ولاية عامة على من يقوم بتغيير
منكره، كأن يكون ذو المنكر هو السلطان ، وولي الأمر الأعلى .
إن كان منكره منكراً خاصاً لا يتعلق بحق الرعية ، فإن كان يفعله
سراً فلمن يراه أن يغيره ، بما يستطيع ، إذا لم يترتب على تغييره منكر أشد
منه ، وأشنع ، وليس له الاعتداء على السلطان بدفع ، أو إيثاق ، أو حبس ،
أو ضرب ، وليس له إفشاء هذا السر في الناس ، حتى يبقى للسلطان في قلوب
العامة هيبة ، ما دام مسلماً .
وإن كان منكره مما يجهر به ، فعلى علماء الأمة تعريفه وتعليمه ، ليكف ما
دام مسلماً يقيم الصلاة ، ثم منعه منه ، وعلى العامة مناصرة العلماء ، دون
إحداث فتنة أشنع من منكره ، الذي يجاهر به ، ما دام هذا المنكر ليس كفراً
بواحاً .
وإن كان منكر السلطان متعلقاً بحق رعيته ، كفرض مكوس وضرائب
ظالمة تنفق فيما لا تنفع المسلمين والرعية ، أو كإشاعة الفسق ، أو مناصرة
الطغاة من رعيته ، واحتجابه عن المظلومين من رعيته ، فعلى العلماء القيام
أولاً بتعريفه الحق ونصحه ، فإن لم يفعل ، ومكث على ذلك ، سعى العلماء إلى
منعه من ذلك ، باتحادهم ، والتصدي له ، وحشد العامة حولهم ، حتى يرتدع
خوفاً على سلطانه ، وليس لهم الخروج عليه بالسيف ، ما دام يعلن إسلامه
ويقيم الصلاة ، فإنه وإن كان ظالماً فاسقاً ، فإنه مسلم ، وفي الخروج عليه
بالسيف فتنة أشد وأنكى من منكره ، لأن في الخروج عليه بالسيف تهديماً
لهيبة الأمة ، في عيون وقلوب أعدائها من الكافرين ، وعلى العلماء السعي
إلى عزله ، بطريق غير طريق السيف .
ولا سيما أن تغيير وعزل الولاة في زماننا له طرق أخرى غير طريق السيف ،
وإذا كان المنكر الواقع من السلطان متعلقاً بإقامة شرع الله تعالى ، والحكم بما أنزل الله ، فإمَّا أن يعلن أن شرع الله هو الحق المطلق ، الكفيل بتحقيق العدالة في الأمة ، وأنَّ الإسلام كتاباً وسنة ، في هديه حل لكل ما تعانيه الأمة ، إلا أنه برغم من ذلك يأخذ من غيره لأسباب ظاهرة أو باطنة ، كأن يكون في تركه شرع الله تعلى تحقيق مصالحه الخاصة الدنيوية ، أو يكون ضعيفاً خواراً أمام قوة داخلية ، أو خارجية ، سعت إلى تنصيبه والياً ، فلا يستطيع مخالفة أمرها ، لقدرتها على التخلص منه بطرق عديدة ، فإن مثل هذا السلطان ظالم ، فاسق ، كفره لا يخرجه عن الإسلام ، ومن ثمَّ لا يجوز الخروج عليه بالسيف ، بل يسعى العلماء إلى مناصحته ، ومكاشفته ، وتبيان الحق له ، بما لا يدع شبهة ، فإن أناب وأصلح ، نوصر وعزّر ، وإلا سعى العلماء والصالحون إلى قيادة الأمة ، لعزله بالحسنى ، التي لا تزهق فيها روح أو يراق دم .
أما إن أعلن السلطان معارضته للشرع، وتصديه لما أنزل الله ، ويرى أن فيما يحكم به صلاح الأمة ، وأن ما حكمت به الأمة في صدر الإسلام ، وما بعده ، لا يتوافق مع واقع الأمة في هذا العصر ، في شؤونها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ولا سيما السياسية الدولية ، فإن مثل هذا كافر كفراً صريحاً ، لأن من يزعم أن ما أنزل الله تعالى : كتاباً وسنة ، لا يصلح لكل زمان ومكان ، ويصلحهما بهديه ، قد أنكر صريحاً من الدين ، فيه برهان من الله ورسوله . فالقرآن كتاب الله تعالى الخالد هديُه للأمة ، المبين لها شؤون حياتها حتى تقوم الساعة ، لا تستقيم حياة الأمة في أي طور من أطوارها ، وأي مناخ من مناخاتها إلا بهديه ، ومن لم يؤمن بذلك ، فقد كفر كفراً مخرجاً عن الملة ، لأنه يعتقد بهذا أن الله عاجز عن أن ينزل ما فيه صلاح الأمة حتى قيام الساعة ، أو يعتقد ، أنَّ الأمة ، بحاجة إلى كتاب ونبي جديد يتناغى ـ في زعمه- مع واقع الحياة المعاصرة ، أو أن الله عجز عن علم ما فيه صلاح الأمة بعد خمسة عشر قرناً من نزول القرآن ، فلم يودع فيه ما يهدي إلى صلاحها من بعد ، وكل ذلك لا يتوقف عاقل في القول ، بأن قائله فيه من الله برهان قاطع ،
بأنه كافراً كفراً مخرجاً من الملة .
{ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } ( النساء : 65 ) ، فإذا ما ثبت كفر السلطان
كفراً مخرجاً من الملة ، فقد وجب على الأمة الخروج عليه ، ونزع يد الطاعة
منه وعزله ، ولو كان عزلاً بالسيف ، فإذا كان لا بد من السيف فهو فريضة ،
لأنه ليس في الأمة أنكى وأنكر من أن يكون سلطانها كافراً بدينها ، وليس
لكافر على مسلم ولاية .
وتلك هي الحالة التي أبيح فيها للأمة بل فرض عليها الخروج على السلطان
وعزله وإن كان بالسيف : حالة كفر السلطان كفراً صراحاً .
(( عن يحيى بن حصين ، عن جدته أم الحصين قال : سمعتها تقول : حججت مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، قالت : فقال : رسول الله صلى الله
عليه وسلم قولاً كثيراً ، ثم سمعته يقول : « إن أُمّر عليكم عبد مُجدع (
حسبتها قالت : أسود ) يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا » .
قوله : ( يقودكم بكتاب الله ) قيد بالغ في استحقاق السمع والطاعة
، فإن قادهم بغيره فلا سمع ولا طاعة ، وهذا ما يصرح به حديث آخر : (( عن
ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « على المرء السمع
والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا
طاعة » .
وفي حديث آخر : « لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف » .
وعن جنادة بن أمية قال : (( دخلنا على عبادة بن الصامت ، وهو مريض فقلنا :
حدثنا ـ أصلحك الله ـ بحديث ينفع الله به سمعتَهُ من رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، فقال :
« دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه ، فكان فيما أخذه علينا ،
أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعُسرنا ويسرنا ، وأثرةٍ
علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، قال : إلا أن تروا كُفرا بواحا عندكم
من الله فيه برهان » .
وقد صرح صلى الله عليه وسلم بالنهي عن قتال الأئمة الظالمين إذا ما صلوا :
عن أم سلمة ـ زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
« إنه يُستعمل عليكم أُمراء ، فتعرفون وتنكرون ، فمن كره فقد برئ
، ومن أنكر فقد سلم ، ولكن من رضي وتابع، قالوا يا رسول الله ، ألا
نقاتلهم ؟ قال لا ، ما صلُّوا » .
بل جاء الأمر بنوع ولاية من يعرض عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ،
(( عن عقبة بن مالك ، قال : « بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية ، فسلمت
رجلا منهم سيفا ، فلما انصرفنا ما رأيت مثل ما لامنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم : قال (( أعجزتم إذ أمًّرت عليكم رجلاً فلم يمض لأمري الذي
أمرتُ ونهيتُ عنه ، أن تجعلوا مكانه آخر يمضي أمري الذي أمرت به أو نهيت
عنه » .
فالإٍسلام يدعو إلى الحفاظ على وحدة الأمة المسلمة خلف وليّ أمرها ، وإن كان عاصياً ، وإن على الأمة أن تؤدي للولي حقه عليها ، وتسأل الله تعالى الذي لها ، وتصبر حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض ، وإن ضرب الإمام الظهر وأخذا المال ، إلا أن يأمر الولي بمعصية ، أو ينهى عن طاعة عن علم ، أو يأتي من الأقوال أو الأفعال ما هو كفر صراح فيه من الله برهان ، كترك صلاة وامتناع عن الحكم ، بما أنزل الله تعالى ، على النحو الذي ذكرنا ، أومناصرة غير المسلمين وتنفيذ مخططاتهم في إذلال الأمة ، أو الإرجاف في قومه بأن أمور العالم من حولها وتصريفها ، إنما هي في يد دولة ما ، غير مسلمة ، لبث روح اليأس في قومه فيركعوا لأعدائها ... إلخ تلك الأفاعيل الماحقة وجود الأمة المسلمة ، وجود عزة ومنعة ، فمثل ذلك لا يسع الأمة قط الصبر عليه ، بل يجب عليها فريضة عين أن تنزع يد الطاعة منه ، وأن تخلع بيعته ، وأن تولي على المسلمين غيره منهم ، يقودهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يكن لها سبيل إلى تحقيق هذا إلا السيف ، فإن السيف أهون من الحياة تحت ولاية مثل هذا السلطان ، وإنَّ السيف حينذاك هو العدل ،
الذي لا تقوم الحياة المسلمة إلا به .
وإذا ما كان هدي الإسلام فيما دون كفر الإمام ، هو الصبر والسمع فيما لا
معصية لله تعالى فيه ، فإنَّ من هديه أيضاً السعي بالحسنى إلى تغييره
واستبدال إمام صالح به ، إذا كان إلى ذلك سبيل حسن ، لا يراق فيه دما ء .
وعلى علماء الأمة بيان ذلك السبيل الحسن ، والدعوة إليه ومناصرته بالحكمة
والموعظة الحسنة .
تغيير المنكر باللسان : أحواله وآدابه
اللسان وسيلة التعريف والتعليم والمناصحة ، والدعوة وبيان الأحكام ، وطرق
الوقاية من المنكرات ، وعلاج ما وقع منها ، ووسيلة التخويف من سوء العقبى
، في الدارين ، لمن ارتكبها ، أو أعان عليها ، أو علمها ورضي بها .
والتغيير باللسان غير محصور في تأنيب وتعنيف من أقدم على منكر ، أو وقع
فيه ، أو التشهير بمن اتخذ المنكر صناعة ورسالة ، فذلك بعض صور التغيير ،
وليس من أعلاها ، بل لتغيير المنكر صورٌ جد كثيرة ، منها ما هو مباشر في
التغيير ، ومنها ما يمكن كل مكلف أن يقوم به ، ومنها ما لا يقوم به إلا
خاصة من المكلفين المسلمين .
· ما يستطيعه كل مسلم من التغيير باللسان غير قليل :
- منه: تبليغ من يكون قادراً على التغيير باليد ، أو غيرها ، حين يكون ذلك
أنجع .وهو عنه عاجز ، كتبليغ ولي الأمر ومن يقوم مقامه بما يراه من منكر .
- ومنه : ذكر الله تعالى بصفات الجلال والقهر وآيات العذاب عند رؤية
المنكر وأهله ، ذكراً مسموعاً ، لينتبه ذو المنكر فيحجم عنه ويكف .
- ومنه : الدعاء لأصحاب المنكرات بالهداية ، والعفو عنهم ،
وتطهير المجتمع من منكراتهم ، والدعاء على المصرِّين المحاربين الله تعالى
ورسوله صلى الله عليه وسلم الساعين بالفتنة ، ليهلكهم الله تعالى ، ويزهق
باطلهم ، فالدعاء ، ولا سيما في السحر من الأسلحة الفاعلة ، والوسائل
الموصلة إلى تغيير المنكر.
· ومما لا يستطيعه إلا من تحققت فيه خصائص التغيير باللسان وآدابه :
- نشر العلم بأسباب الوقوع في المنكر ، وعواقبه ، وطرائق الوقاية منه ،
وأفانين المرجفين به في المدينة وأثرهم في الأمة ... إلخ ، سواء كان هذا
النشر شفاهياً ، أو كتابياً .
- ومنه : التشهير بسير المحاربين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ،
الساعين في الأرض فساداً ، ممن ينتسبون للإسلام جهاراً ، ففي كشف هؤلاء ،
وما يمكرون ويكيدون للمسلمين ، ونقض افتراءاتهم ودحضها ، تغيير بالغ
للمنكر .
والقول بأن تغيير المنكر باللسان ، إنما هو للعلماء ، منظور فيه إلى بعض
صوره التي لا يقوم بحقها إلا العلماء ، وليس عاماً في كل صور التغيير
باللسان ، فإنَّ منها ما يستطيعه كثير من الأمة .
· وللتغيير باللسان أحوال كالتي ذكرناها في التغيير باليد ، وآداب لكل
حالة :
- إذا كان المغيِّر ذا ولاية خاصة على ذي المنكر كأن يكون
المغيِّر هو الوالد أو الزوج ، فإنه يقوم بالتغيير باللسان أيضاً ، دون
إذن من الولي الأعلى ، وعليه أن يقوم بكل صور هذا التغيير ، متى كان
مجيداً لها .
- وإذا كان المغيِّر ذا ولاية عامة على ذي المنكر ، فالأمر كذلك ، وعليه
أن يكلف من الرعية من يقوم بذلك ويرعاه ، فإن من حق الرعية على ولي الأمر
، أن يحميها من كل ما يوقع بها ضرراً من غيرها ، أو من بعض أبنائها ..
عليه أن يحمي عقيدتها الصحيحة ، وأن ينقيها من كل ما هو غير مشروع ، وأن
يحمي علمها وثقافتها النافعة ، وأن يحمي اقتصادها من الربا والكساد
والبوار ، وأن يحمي صحتها من الأدواء الفاتكة ، وأن يحمي كل شيء فيها من
كل ما يمكن أن يلحق بأحد منها ضرراً .
- وإذا كان المغيِّر وذو المنكر ، ليس لأحدهما على الآخر ولاية عامة أو خاصة ، بل بينهما علاقة الإخاء الإيماني ، التي هي أوثق العلائق ، فإن لكلّ أن يغير بلسانه منكر غيره ، فيما يستطيعه ويجيده ، ولا سيما ما يكون عاماً من صور التغيير باللسان ، التي سبقت الإشارة إليها ، فإن كان من أهل العلم ، المشهود لهم من العلماء ، فإن عليه فريضة ، أن يغير بلسانه المنكر ، ولا يحتاج في هذا إلى إذن خاص من ولي الأمر المسلم ، المقيم شرع الله تعالى ، لأن معه إذناً عاماً ، فهذه رسالة أهل العلم التي كلفهم بها الإسلام ، ولا يجوز لأحد من أهل العلم ، أن يتقاعس أو يتشاغل عن أداء تلك الرسالة . وإن كان الوالي لا يقيم شرع الله ، فعلى العلماء أيضاً التغيير باللسان ولا يتوقف هذا على إذن من أحد ، متى التزم العالم بأدب التغيير باللسان ، وعلى العامة مناصرة العلماء في هذا ، حتى لا يسعى مثل ذلك السلطان إلى إلحاق الضرر بهم ، أو بأحد من أهليهم ، أو منعهم من أداء رسالتهم .
- وإذا كان لذي المنكر ولاية خاصة على من يقوم بالتغيير ، كأن
يكون والده ، أو يكون زوج من تريد تغيير منكره ، فإن بعض صور التغيير
باللسان لا يجوز للولد أو الزوجة فعلها ، كالتعنيف والتشهير وإغلاظ القول
، وما شابه ذلك ، أما بيان المنكر وعقباه ، والدعاء بالهداية والوعظ
بالحسنى ، فذلك لهما أو عليهما . وكذلك عليهما أو لهما إبلاغ من يحسن
القيام بتغيير منكرهما ، إذا ما خشي الولد أو الزوجة ، أن يتجاوز أحدهما ،
فإن التجاوز في نفسه منكر يجب مع ظن الوقوع فيه الاستعانة بآخرين .
- وإذا كان لذي المنكر ولاية عامة كالسلطان ، فإن تغيير منكره باللسان من
الرعية ، يرجع إلى نوع المنكر :
إن كان منكره خاصاً به ، مستوراً لا يجاهر به ، فعلى من يراه ممن حوله من
بطانته مناصحته بالحسنى ، والدعاء له بالهداية ، وبالستر أيضاً ، حتى لا
تسقط هيبته من قلوب الأمة ، إذا ما كان مسلماً يقيم الصلاة .
وإن كان منكره خاصاً غير مستور ، فعلى علماء الأمة مناصحته
بالحسنى، وبيان الهدى والحق ، والدعاء له بالتوبة والصلاح ، وتعليم الأمة
بغض فعله ، دون خروج عليه ، ما دام مسلماً يقيم الصلاة ، فإن تاب وأناب ،
نوصر وعزّر ، وإن لم يتب سعت الأمة إلى عزله بالحسنى ، دون فتنة هي أكبر
من منكره ، وإلا كان الصبر فريضة حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً .
وإن كان منكره عاماً يتعلق بحق الأمة ، ولم يكن منكراً يدخل به باب الكفر
المخرج من الملة ، فإن على علماء الأمة السعي إليه ، لمناصحته وإرشاده
وتعليمه ، ثم إلزامه بأن يقضي في الأمة بالعدل ، وعلى العامة مناصرة
العلماء وتأييدهم ، ولا يجوز للعلماء مناصحته علانية ، متى تيسرت مناصحته
سرًّا ، فإن مناصحته علانية ، أو ذكر مناكيره ، تعين العامة على الخروج
عليه ، كما أن المجاهرة بنصيحة السلطان ، تدفعه إلى الاستهتار في المنكر
والإصرار عليه .
وليس لعالم ، له إلى سلطان سبيل مناصحته في سرٍ، أن يتقاعس أو يتشاغل عن
مناصحته ، والإخلاص فيها ، والاستعداد للوفاء بحقها ، وليس له أن يستبدل
بهذه المناصحة في السر ، مناصحة في العلانية ،
(( عن شقيق ، عن أسامة بن زيد ، قال : قيل له : ألا تدخل على
عثمان فتكلمه ، فقال : أترون أني لا أكلمه إلا أُسِمعكم . والله ، لقد
كلمته فيما بيني وبينه ، ما دون أن أفتتح أمراً لا أحبُّ أن أكون أول من
فتحه )) .
وهذا كله إذ أمكن ذلك ، فإن لم يمكن الوعظ سرًّا والإنكار ، فليفعله
علانية لئلا يضيع أصل الحق )) .
وعلى العامة الوقوف مع علماء الأمة ومناصرتهم ، والذَّب عنهم وتكثير
سوادهم حتى يرسخ في قلوب الولاة هيبتهم ، وأنَّ من ورائهم الأمة إذا ما
دعوا إلى الحق ، فيخضع أولئك الولاة لذلك الحق .
وتاريخ علماء الأمة حافل بالتصدي لقول الحق في وجه الولاة حين ينحرفون
علانية عن الحق ، وسياق رواية حديث ( تغيير المنكر لمن رآه ) والذي سبق
ذكره ، فيه الدلالة على ذلك حيث قام رجل إلى الوالي ، حين أراد مخالفة
السنة ، بتقديم خطبة العيد على صلاتها ، فأنكر بلسانه ، فقال أبو سعيد
الخدري : أما هذا فقد قضى ما عليه .
وفي رواية للبخاري : أنَّ أبا سعيد فعل ذلك أيضا مع مروان ، وهو
أمير المدينة ، فأراد أن يخطب قبل الصلاة ، يقول أبو سعيد : (( فجبذت
بثوبه ، فجبذني ، فارتفع ، فخطب قبل الصلاة ، فقلت له : غيّرتم والله ،
فقال : أبا سعيد ، قد ذهب ما تعلم ، فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم
، فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة ، فجعلتها قبل الصلاة
)) .
فأبو سعيد أنكر على مروان ، وسعى إلى تغيير منكره باليد وباللسان ( فجبذت
بثوبه ) ( فقلت له : غيرتم والله ) .
وقد حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على قول الحق لمن جار من الولاة : ((
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضل
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر )) أو (( أمير جائر » .
فإن كان السلطان لا يقيم الشرع إعراضاً عنه ، أو لا يقيم الصلاة ، أو ينكر
معلوماً من الدين لا يستقيم بدونه إيمان ، كصلاة أو صيام أو جهاد ، فإن
ذلك السلطان كافرٌ كفراً يخرجه من الملة ، ولا يليق بالأمة السكوت عليه ،
ويجب عزله ولو بسيف ، إن كان لا بد من السيف ، وإلا فغيره أنفع وأحمد
سبيلاً إلى عزله .
تغيير المنكر بالقلب : أحواله وآدابه
يُفَسَّرُ التغيير بالقلب بأنه كره المنكر ، وأن هذا ليس بإزالة ، وتغيير
من فاعله للمنكر ولكنه هو الذي وسعه ، وفي هذا نظر .
إذا كان كره المنكرات وأصحابها ، فعلاً قلبيَّاً ، فإن له واقعاً سلوكياً
في حياة صاحبه يصدق ذلك الكره أو يكذبه ، فإن من آيات أو ثمرات كره
المنكرات ، الإعراض عنها ، وعن أصحابها ، واجتنابهم ، والاعتصام من
الاختلاط بهم ، وفعل ما يمكن أن يعود عليهم بنفع دنيوي ، ووجوب إظهار بغض
أفعالهم واحتقارهم ما داموا على منكرهم ، ووجوب قطيعتهم في شتى حركات
الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، ولا سيما المجاهرون منهم
بمنكراتهم .
وسبيل مقاطعة أهل المنكر المجاهرين والمرجفين في المدينة ، به ضرب من ضروب
التغيير المؤثرة ، وهو مما لا يعجز عنه أحد أبداً .
وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ هذا السبيل في واقعة الذين
تخلفوا عن غزوة العسرة : { وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا
حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ } ... الآية )
( التوبة : 118 ) .
وقد وصف (( كعب بن مالك )) ما كان من تلك القطيعة البالغة الأثر
وصفاً فيه الهداية إلى المنهاج الأمثل في سبيل تغيير المنكر بالقلب .
إنَّ مجرد عدم الرضا القلبي عن المنكر وصاحبه ، لغير كافٍ في تغيير المنكر
، ولا يعد صاحبه مغيِراً ، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل
القلبي تغييراً نظراً لثمرته ، التي ينبغي أن تنبثق من هذا الكره القلبي .
(( عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : « إنَّ أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل ،
فيقول : يا هذا ، اتَّق الله ، ودع ما تصنع ، فإنه لا يحلُّ لك ، ثم يلقاه
من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب
الله قلوب بعضهم ، ثم قال : { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ }{ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ
مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ }{ تَرَى كَثِيرًا
مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ
أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ
خَالِدُونَ }{ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا
مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } .
ثم قال : كلا ، والله لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذنَّ على
يدي الظالم ، ولتأطرُنه على الحق أطرا ، ولتقصرونه على الحق قصرا » .
وفي رواية زادت : « أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم
ليلعنكم كما لعنهم » .
ففي هذا آيات باهرات على أن من التغيير القلبي ، مقاطعة أصحاب المنكر وترك
مخالطتهم ، وذلك الذي لا يعجز عنه أحد ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم
هذا التغيير (( أضعف الإيمان )) ولهذا الحكم عدة وجوه من المعنى أعلاها :
إن تكاليف هذا السبيل من التغيير أضعف تكاليف الإيمان، فكل من تلبس
بالإيمان هو قادر عليه . ولذلك جاء قوله هذا مناظراً لقوله ( فإن لم يستطع
) في الضربين الأولين : التغيير اليدوي واللساني ، فكأنه قال فليغيره
بقلبه ، وهذا يستطيعه كل مسلم ، لأنه أضعف الأيمان . وهو يتناسق من وجه مع
قوله في رواية أخرى : « وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » ، أي وليس
وراء هذا التكليف من تكاليف الإيمان حبة خردل ، فهو أخفها وأيسرها .
وعلى هذا لا يكون قوله : « وذلك أضعف الإيمان » وصفا بالضعف لإيمان من عجز
عن التغيير اليدوي أو اللساني ، ولكنه قام بحق التغيير القلبي ، بل هو وصف
بالضعف واليسر ، لما كلف به من عجز به ، من عجز عن التغيير اليدوي
واللساني ، أي ما كلف به من تكاليف الإيمان ضعيف يسير ، لا يعجز عنه أحدُُ
أبداً .
لأن من عجز عن التكليف الأعلى ، وقام بحق التكليف الأدنى ، لا
يوصف إيمانه بأنه ضعيف ، بل إيمانه قوي . فمن عجز عن الصلاة قائماً وصلى
جالساً صلاة تامة ، لا يوصف إيمانه بالضعف ، بل يوصف ما كلف به بأنه أيسر
مما كلف به غيره وأضعف ثقلاً .. فالإيمان لا يوصف بالضعف ، إلا إيمان من
ترك ما هو قادر عليه ، وأما من عجز عن أمر ، وقام بحق ما استطاعه ، فإنه
لا يوصف إيمانه بضعف ، وإن وصفت تكاليف ما قدر عليه بأنها أضعف من تكاليف
ما عجز عنه .
ويذهب جماعة إلى أن هذا وصفُُ لثمرة هذا التغيير القلبي ، فقوله : ( أضعف
الإيمان ) أي أقله ثمرة ، وهو مقبول ، إذا ما ناظرنا ثمرة التغيير القلبي
بثمرة التغيير اليدوي واللساني من وجه ، وإن كانت ثمرة هذا التغيير القلبي
قد تكون مع بعض المنكرات أعظم أثراً من غيرها ، ولذلك فعلها النبي صلى
الله عليه وسلم مع الذين تخلفوا عن غزوة العسرة.
المعنى الذي أذهب إليه : إنه وصف لتكاليف التغيير القلبي ، وليس وصفاً
لثمرته أو وصفاً لإيمان فاعله القائم بحقه ، العاجز عن التغيير اليدوي
واللساني .
والتغيير القلبي للمنكرات على النحو الذي كشفنا عن حقيقته :
كُرهُُ قلبي ، تصاحبه استجابة سلوكية لمقتضياته ، إنما هو فرض عين على كل
مسلم ذكراً أو أنثى أياً كان وضعه في العلم والجهل ، والغنى والفقر ،
الصحة والمرض ، فهو لا يسقط عن أحد مادام مكلفاً .
وهو ملازم لما هو أعلى منه تكليفاً ، فمن استطاع التغيير اليدوي لزمه معه
أيضاً التغيير القلبي ، وكذلك مستطيع التغيير اللساني يلزمه التغيير
القلبي على النحو الذي شرحناه .
وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ التارك للمنكرات فعلاً وقولاً
لكنه يخالط أهلها ، وغير غاضب لله عز وجل بشأنها ، إنما هو من أهل
المنكرات أيضاً ، لا يقل عنهم شناعة إثم واستحقاق عقوبة .
(( عن جابرٍ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أوحى الله عز وجل
إلى جبريل ـ عليه السلام ـ أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها ، قال : يا ربّ
إن فيهم عبدك فلاناً لم يعصك طرفة عين ، قال ، فقال : اقلبها عليه وعليهم
، فإنَّ وجهه لم يتمعَّر فيَّ ساعة قطُّ » .
والناظر في حال كثير من الناس ، يرى تخلياً عن جميع مراتب تغيير
المنكر وسبله : التغيير اليدوي ، واللساني ، والقلبي ، ولا يعين أحداً على
شيء من ذلك التغيير . بل ترى كثيراً من العامة يبتهجون بمعرفة وصحبة
المتمرسين بالمنكرات ، ويفتخرون بمعرفتهم أو مشاهدتهم ومصافحتهم ومعرفة
دقائق أخبارهم ، هذا ما تراه في حال كثير من العامة مع أصحاب المنكرات
المجاهرين بها الساعين إلى إشاعة الفاحشة في الأمة عن عمدٍ وتآمر مع أعداء
الأمة من الماسونيين والصهيونيين والماركسيين والعلمانيين .
إن الإعجاب بالطواغيت والمحاربين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهل
الفسق والفاحشة ، ليكاد يشيع في شبيبة الأمة وشيبها ، مما يكاد ينزل بها
من الله عز وعلا ، من اللعن والغضب ، مالا يبقي ولا يذر .
العجز عن التغيير باليد أو اللسان
إذا ما كان تغيير المنكر ذا مراتب ثلاث ، فإنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد قيد فرضية التغيير باليد بالاستطاعة ، وكذلك التغيير باللسان ، فإن عجز عن الأولى ، انتقل إلى الثانية ، فإن عجز عنها أيضاً انتقل إلى الأخير (التغيير القلبي).والعجز نوعان : حسيّ ومعنوي . يكون الحسي ّ لمرض أو فقد الأداة التي يكون بها التغيير ، فيقدر العفو بقدر العجز : { بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ }{ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ } ( القيامة : 14- 15 ) ، فإن تحقق العجز الحسيّ عن مباشرة التغيير اليدوي أو اللساني بقي وجوب إعانة من هو غير عاجز إعانةً مستطاعةً مثل المناصرة والمؤازرة ، وتكثير السواد ، والدعاء له بالتوفيق والتثبيت ، وإخلافه في أهله إن غاب ، ومناصحته والتواصي بالحق وبالصبر .
(( عن زيد بن خالد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من جهَّز غازيا في سبيل الله فقد غزا » ( متفق عليه ) .
ويكون العجز المعنوي في صور عديدة ، منها ما يملك المرء إزالته والاعتصام منه ، ومنها ما لا يستطيع إزالته .
مما يستطاع إزالته : العجز العلمي ، فمن لم يستطع تغيير المنكر
لجهله به أو بآدابه وضوابطه ، وجب عليه السعي إلى أن يتعلم ، ما يجهل ،
حتى يقوم بهذه الفريضة ، التي يحسن تحقيقها على نحو يحقق للأمة رسالتها .
وإزالة العجز العلمي قد تيسرت طرائقه ، فمنه ما لا يكلف جهداً ولا مالاً
لما يبذله أهل العلم من نشر العلم النافع .
ومن العجز الذي قد لا يستطاع إزالته لبعض الأمة : خوف مكروه على النفس أو
الأهل ، وهو درجات وأحكام :
· إذا خاف المرء على نفسه القتل لذلك ، وعلم أن في قتله بذلك نفعاً وأثراً
عاجلاً أو آجلاً ، فإن كان من أهل العلم المقتدى بهم ، فالأعلى والأوجب
ألا يصده هذا عن القيام بحق التغيير باليد أو اللسان ، فقد ندبت السنة
لذلك.
روى الحاكم مرفوعاً عن جابر : « سيد الشهداء حمزةُ بنُ عبد المطلب، ورجلُُ
قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله » .
وروى مسلم بسنده عن (( صهيب )) حديثاً طويلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عن غلام ممن كان قبلنا ، بحث عن الحق والهدى حتى علمه وآمن به ودعا إليه ، وعاش له ، فتوعده الملك إن لم يكف عن دعوته قتله ، فوجد أن في قتله نفعاً للدعوة فصبر ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « فقيل له : ارجع عن دينك ، فأبى، فدفعه إلى نفرٍ من أصحابه فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا ، فاصعدوا به الجبل ، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه ، فذهبوا به فصعدوا الجبل فقال : (( اللهم اكفنيهم بما شئت )) ، فَرَجَفَ بهم الجبل ، فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك ، فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ قال كفانيهم اللهُ ، فدفعه إلى نفر من أصحابه ، فقال : اذهبوا به فاحملوه على (( قُرقُورٍ )) فتوسطوا به البحر ، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه ، فذهبوا به ، فقال : (( اللهم اكفنيهم بما شئت )) فانكفأت بهم السفينة ، فغرقوا ، وجاء يمشي إلى الملك ، فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ قال كفانيهم اللهُ ، فقال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به ، قال : وما هو ! قال : تجمع الناس في صعيد واحد ، وتصلبني على جذع ، ثمَّ خذ سهما من كنانتي ،
ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل : باسم الله رب الغلام ، ثم
ارمني به فإنك إن فعلت ذلك قتلتني ، فجمع الناس في صعيد واحد ، وصلبه على
جذع ثم أخذ سهما من كنانته ، ثم وضع السهم في كبد القوس ، ثم قال : باسم
الله ربِّ الغلام ، ثم رماه ، فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في
موضع السهم فمات .
فقال الناس : آمنا برب الغلام ، آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام ، فأتى
الملك ، فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر ؟ قد والله نزل بك حذرك ، قد آمن
الناس ، فأمر بالأخدود في أفواه السّكك فخدّت ، وأضرم النيران ، وقال من
لم يرجع عن دينه فاحموه فيها ، أو قيل له : اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة
ومعها صبّي لها ، فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام : يا أمه ، اصبري ،
فإنك على الحق » .
في هذا القصص الحق دلالة باهرة وإيذان بالغ بأن تضحية الداعية والعالم
والقدوة بنفسه في سبيل دعوته الحقة ذات أثر عظيم ، ونفع عميم للدعوة
وتأجيج جذوة الاستمساك بها في صدور الأمة ، فيكون ذلك أنفع للدعوة .
والعالم الداعية ذو الحكمة قادر ـ بعون الله تعالى ـ على أن يقدر الأمور
بما هو أنفع وأنجع .
وكل ذلك من باب العزيمة التي هي أليق بحال أهل العلم والدعوة ،
ويبقى لهم باب الفسحة والرخصة مفتوحاً ، فمن خاف القتل إن غيّر المنكر ،
فله أن يدعه حتى يزول خوفه ، ولكن الصبر والتضحية أعلن وأسمى .
يقول (( ابنُ بطّال )) : (( النصيحة لازمة على قدر الطاقة إذ علم الناصح
أنه يُقبل نصحه ويُطاع أمره ، وأمن على نفسه المكروه ، فإن خشي على نفسه
أذىً ، فهو في سعة ) .
ويجعلون له في سيدنا (( هارون )) عليه السلام في هذا أسوة ، فقد كفّ عن
بني إسرائيل ، وحملهم عن تغيير منكر عظيم هو عين الشرك حين خشي على نفسه
القتل :
{ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ
بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ
وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ
قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا
يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }{ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي
وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ } (
الأعراف : 150 ـ 151) ,
يقول ابن العربي : (( وفي هذا دليل على أن لمن خشي القتل عند
تغيير المنكر ، أن يسكت عنه )) .
في هذا الاستدلال نظر مفصل :
إنَّ سيدنا (( هارون )) إنما كف عن منع بني إسرائيل ، بعد أن بلغ في ذلك مبلغا عظيما ، وخشي على الدعوة ، وهو خليفة أخيه (( موسى )) عليهما السلام ، فلو أنه قتل ، وليس فيهم (( موسى )) عليه السلام لكانت آثار ذلك جدَّ فادحة على الدعوة فأيقن بنور النبوة وحكمتها ، أن الصبر عليهم ، وترك التصدي لهم ، حتى يعود موسى عليه السلام ، أنفع وأعلى للدعوة وللأمة ، من الإقدام على التصدي والاستشهاد في سبيل الله ، فإن في الاستشهاد خيره وحده ، وهو إنما يريد الخير للأمة والدعوة ، فسيدنا (( هارون )) عليه السلام ما سكت مخافة قتله فقط ، (( إنما خشي تفرق الأمة من بعد قتله : { إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي } ( طه : 94 ) ، فحرصه على القيام بحق ما كلفه به (( موسى )) عليه السلام ، وهو ذاهب إلى الميقات { اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ } ( الأعراف : 142 ) ، وهو السبب الرئيس إلى كف سيدنا (( هارون )) عليه السلام عن التصدي لهم ، من بعد أن بلغ في دعوتهم والتصدي لهم مبلغاً عظيماً .
وللعالم الداعية في ذلك أسوة حسنة ، فإذا ما رأى أن تصديه للمنكر
وإقدامه على الاستشهاد في سبيل الله تعالى ، خسران بالغ للدعوة والأمة ،
وإن كان فيه نفع له وحده ، أن يقدم صالح الدعوة والأمة على صالحه هو ،
وذلك كأن يكون إماماً في قومه ذا منهج بديع في الدعوة وذا أثر نافذ في
القلوب لا يتحقق من غيره كمثل تحققه منه ، وأنه يستفاد منه سالماً في
الأمة أكثر من استشهاده ، فليكن حرصه حينذاك على سلامته من القتل أولى
وأعلى من حرصه على استشهاده ، حتى يتمكن من تربية قادة يخلفونه وأجيال
تحمل أمانة الدعوة من بعده .
أما إن رأى العالم بحكمته أنّ في صبره واستشهاد إلهاباً وتأجيجاً لجذوة
الانتصار للحق في قلوب الأمة ، وكان في الناس من يخلفه في الدعوة ،
فالأعلى أن يصبر حتى يقتل .
· وإن كان الخائف على نفسه القتل ، ليس من أهل العلم والقدوة ، فأحبّ إليّ
أن يدع ذلك التغيير حتى يزول ما يخشاه ، ما دام في الأمة من يقوم به ممن
هو الأعلى منه من أهل العلم ، شريطة أن يناصرهم بما يستطيع ، وأن يخلفهم
في أهليهم .
أما الخوف على الأهل ، ولا سيما الوالدان والزوجة والأولاد ،
فالأحب إليّ أن يقدر العالم القدوة حالهم ، فإن كان أهله ممن لا يفتنون في
دينهم ، وكان القتل أحب إلى نفوسهم ، وكان القتل أيضاً أنفذ أثراً في
الدعوة ، وأهزُّ لعروش الطغيان ، فالأولى القيام بحق التغيير ، والصبر على
الإيذاء والقتل { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } ( العنكبوت : 69) .
أما إن كانوا ممن يخشى عليهم الفتنة في الدين ، فالأعلى بل الأوجب حمايتهم
من الفتنة ، بالكف عما يؤدي إليها من تغيير المنكر باليد أو اللسان ، حتى
يزول ما يخشاه عليهم وحتى يرقى إيمانهم إلى درجة الرسوخ والصمود أمام
المحن .
وإذا ما كان حال الخوف على الأهل ، لذوي العلم والقدوة ، فإن حال غيرهم من
العامة أولى بحمايتهم من الفتنة ، بالكف عما قد يسبب تعرضهم للفتنة في
دينهم .
· وإذا خاف المرء على نفسه وأهله التعذيب الجسدي ، أو المعنوي الفاتن ، فتُقدرُ الأمور بقدرها . إن كان قادراً على الصبر واحتماله ، موقناً أنَّه لن يفتن في دينه ، فالأعلى له وللدعوة وللأمة أن يستعين بالله تعالى على ذلك ، ويصبر ، ويصابر فيغير المنكر الذي رآه ، سواء كان من العلماء القدوة أو ممن هم دون ذلك ما دام قد تحقق التيقن على الصبر والاحتمال . وأهل العلم وطلابه أولى بذلك من غيرهم ، فإن الله تعالى ـ قد نعى على من يدعي الإيمان ولا يصبر على تكاليفه ، وعلى مقتضيات الدفاع عنه ونشره .يقول جل جلاله { الم }{ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ }{ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ } ( العنكبوت : 1 -3 ) .
فما كان الإيمان قط كلمات تلوكها الألسنة ، وإلا لما توقف في
قولها كفار مكة حين طولبوا بالإيمان ، وإنما هو تكاليف ومجاهدة ومصابرة ..
ودعوى القيام بتلك التكاليف ، يحتاج بيان الزائف منها والخالص ، إلى
ابتلاء وفتنة كمثل فتنة النار الذهب ، فلا يبقى منه إلا ما خلص ونصح، فمن
أذهبت الفتنة دعوة الإيمان من قلبه ، فهو الكذاب الأشر في دعواه الإيمان .
وهذا الأنموذج المتخاذل المستخدم أمام الفتنة والبلاء ، شاخص في كل جيل :
{ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي
اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ
نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ
اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ } ( العنكبوت : 10 ) .
وما كان الله مصوراً بهذا من ضعف لحظة عن احتمال الفتنة ، ولكنه يصور بهذا
من جعل فتنة الناس كعذاب الله ذلك الذي اختلطت في حسه الفارقات بين ما هو
من عذاب الله ، وما هو من فتنة الناس ، فحسب أنهما سواء ، ومثل هذا لا
يقوم في قلب خالطه الإيمان مهما بلغ الناس في فنون الفتنة والتعذيب ، فكل
فتنة ومصيبة دون النار عافية .
فمن ادعى الإيمان ولم يصبر على الفتنة فيه ، كانت دعواه سرابا ،
ولذا كان من مقتضيات دعوى الإيمان : الثبات عليه ، واتخاذ الأسباب المحققة
للصبر على تكاليفه ، وقد حكى الحق موعظة (( لقمان )) لابنه لنتأسى بها : {
يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ
الْأُمُورِ } ( لقمان : 17) .
فهذه الدعائم الأربع لنجاح الداعية : إقامة الصلاة ، بكل ما تتطلبه من
مقتضيات في بناء شخصية الداعية ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بكل
ما يتطلبانه من زاد وفير لتكوين شخصيته ، وتحقيق القيام بتلك الفريضة
البالغة الأثر في تحقيق قيام الأمة المسلمة الرائدة القائدة ، المخرجة
الناس من جور السلاطين إلى عدل الإسلام ، ثم الصبر على ما يلقاه الداعية
من أهل الباطل من كل صنوف وفنون الافتتان والابتلاء .
وفي قصِ القرآن موعظة (( لقمان )) ابنه ، إيذان بالغ بالأمر
الإيجابي بما تضمنته من هذه الدعائم الأربع . فإنَّ أهل العلم ليذهبون إلى
أنَّ سنَّة البيان القرآني في الأمر بالفعل : الإخبار عنه أو عن صاحبه في
سياق المدح ، أو الرضا عنه أو عن صاحبه ، وذلك ما هو الجلي في القصص
القرآني وما يحكيه من أخبار السابقين .
المسلم القوي الإيمان ، جدير بأن يصبر على الفتنة والابتلاء ، وجدير به
قبل التصدي للدعوة إلى الله تعالى ، وإلى تغيير المنكر بيده ، أو لسانه ،
أن يدرب نفسه وأهله على الصبر على الابتلاء ، وعلى الصمود أمام المحن ،
وأهوال التعذيب ، الذي يبدع فيه الطواغيت وشياطينهم .
إنَّ صبر الدعاة وأهليهم على تعذيب الطغاة ، لينكأ في سويداء الطواغيت
أعظم من السهام المسمومة ، وإنَّ مضاجعهم لتُقضُّ بهم من مصابرة الدعاة
ومرابطتهم واحتسابهم ما يلقونه من تعذيبهم ونكالهم .
وفي القرآن حث بالغ على الصبر والمصابرة في سبيل الإيمان ، والدعوة إليه ،
والدفع عنه ، وتغيير المنكر : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
} ( البقرة : 153 ) .
{ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ
سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا
يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
} ( آل عمران : 120 ) ؟
{ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ
مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ } ( آل عمران : 186).
{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } ( آل عمران : 200 ) .
وعلى الرغم من ذلك ، فقد جعل الله لمن خشي على نفسه ، أن يمسك عن
التغيير باليد أو اللسان ، بل أذن له فيما فوق ذلك : أذن له أن يكفر
بلسانه وحده مع اطمئنان قلبه بالإيمان إذا ما خشي على نفسه : { مَنْ
كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } ( النحل :
106) .
· فإذا خاف المرء على عرضه أو عرض أهله ، بانتهاك حرمته ، كمثل ما يفعل
الطواغيت الآن في المعتقلات والسجون ، فإنّ الأعلى في هذه الحال أن يكف
المسلم عن تغيير المنكر بيده أو لسانه ، ويقيم على تغييره بقلبه ، على
النحو الذي وضّحناه ، فإن حفاظ المسلم على عرضه وعرض أهله أولى وأوجب من
الحفاظ على نفسه وأهله وماله .
والطواغيت اليوم يعلمون أنه لا يفت في عضد الدعاة كمثل ما يلم
بأعراضهم ، فإذا بهم اليوم يسلكون ذلك المسلك الماحق : { وَقَدْ مَكَرُوا
مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ
لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ }{ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ
وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ } ( إبراهيم : 46
ـ 47 ) .
{ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ
بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَشْعُرُونَ }{ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ
بِمُعْجِزِينَ }{ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ } ( النحل : 45 ـ 47 ) .
تلك الأحوال الثلاثة ، التي ينظر في أثرها في من يقوم بتغيير المنكر ،
بيده أو بلسانه ، كفاً عنه ، أو إبلاغاً في القيام به : حال الخوف من
القتل على نفسه أو أهله ، حال الخوف على النفس أو الأهل من انتهاك العرض .
أما دون ذلك من صور الخوف وأحواله ، كإيذاء في مال أو عمل أو غير
ذلك ، فإن الذي تقتضيه المسؤولية الإيمانية الجهادية على كل مسلم ومسلمة
الحرص البالغ على الانتصار للدعوة ، والقيام بحق تغيير المنكر بما يسع
المرء من يد أو لسان ، واحتساب كل ما يلقاه من إيذاء وأضرار دنيوية في
ماله وعمله وجاهه وراحته وطمأنينته وحريته المكفولة له شرعاً ، فلا يليق
بمسلمٍ يعتز بإسلامه أن يجعل حرصه على ماله أو وظيفته أو تجارته ... إلخ
أحبَّ إليه وأعزَّ عليه من الله عزَّ وعلا ، ومن رسوله صلى الله عليه وسلم
وتطهير الأمة من المنكر .
{ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } ( التوبة : 24).
(( وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده ، إنما تطالب به الجماعة
المسلمة ، فما يجوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة ، يرتفع على
مقتضيات العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد في سبيل الله .
وما يكلف الله الفئة المؤمنة هذا التكليف ، إلا وهو يعلم أنَّ فطرتها
تطيقه .. فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وإنه لمن رحمة الله ، بعباده أن
أودع فطرتهم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال ، وأودع فيها الشعور
بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدلها لذائذ الأرض كلها .. لذَّة الشعور
بالاتصال بالله ، ولذة الرجاء في رضوان الله ، ولذة الاستعلاء على الضعف
والهبوط والخلاص من ثقلة اللحم والدم ، والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء
، فإذا غلبتها ثقلة الأرض ، ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة
في الخلاص والفكاك )) .
وفي قوله تعالى : { فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ } ،
تهديد بالغ لمن لم ينعتق من أسر حبَّ الأهلين ، ومتاع الحياة الدنيا ،
وتفضيله على حبَّ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والجهاد في سبيل
الله جل جلاله .
وفي هذا إيذان عظيم بأن الجهاد في سبيل الله تعالى ، ومنه تغيير
المنكر ، لا يعفي منه الخوف على الأهلين فيما دون القتل والفتنة في الدين
والعرض :
(( عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فكان
فيما قال : « ألا ، لا يمنعنَّ رجلا هيبةُ الناس أن يقول بحقَّ إذا علمه »
، قال : فبكى أبو سعيد : وقال : قد والله رأينا أشياء فهبنا )) .
وعن عبادة بن الصامت قال : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على
السمع والطاعة ، في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، وأن لا ننازع الأمر
أهله ، وأن نقول بالحق حيثما كنا ، ولا نخاف في الله لومة لائم » .
وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يُحقِر
أحدُكم نفسه )) ، قالوا : يا رسول الله ، كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : ((
يرى أمرا لله عليه فيه مقال ، ثم لا يقول فيه ، فيقول الله عز وجل له يوم
القيامة : ما منعك أن تقول في كذا وكذا ، فيقول خشيت الناس ، فيقول :
فإياي كنت أحقُّ أن تخشى » .
ومجمل الأمر : أن الخوف على عرض من أعراض الحياة الدنيا ، ليس من صور العجز المانع من الاستطاعة التي هي شرط التكليف بتغيير المنكر باليد أو اللسان ، ولم يجعل لمن خاف على عرض من دنياه ، فسحة في أن يدع تغيير ما يراه من منكر بيده أو لسانه إذا ما كان أهلاً للتغيير اليدوي أو اللساني .
فاصلة القول
إذا ما كان جليًّا أنَّ تغيير المنكر إنما هو لدرء المفاسد ، كيما يتحقق الوجود المتمكن للأمة المسلمة ، فإنه إذا ما تيقن المسلم ، أو غلب على ظنه الراشد ، أن تغييره منكراً سوف يترتب عليه وقوع منكر أعمّ ، أو أبقى أو أنكى أثراً ، فجمهور أهل العلم يذهبون إلى ترك تغيير ذلك المنكر إلى الأدنى ، دفعاً لوقوع ما هو فوقه .يقول (( ابن القيم )) : إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه ، وأبغض إلى الله ورسوله ، فإنه لا يسوغ إنكاره ، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله ، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم ، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدَّهر ...
ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار ، رآها من
إضاعة هذا الأصل ، وعدم الصبر على منكر ، فطلب إزالته ، فتولد منه ما هو
أكبر منه ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات
ولا يستطيع تغييرها ، بل لمّا فتح الله مكة ، وصارت دار إسلام ، عزم على
تغيير البيت وردَّه على قواعد إبراهيم ، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه ،
خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام ،
وكونهم حديثي عهدٍ بكفر ، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد ،
لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه ... فإنكار المنكر أربع درجات :
( الأولى ) أن يزول ويخلفه ضده .
( الثانية ) أن يقل وإن لم يزل بجملته .
(الثالثة ) أن يخلفه ما هو مثله .
( الرابعة ) أن يخلفه ما هو شر منه .
فالدرجتان الأوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمة ))
( 66 ).
وتقدير درجات المنكر في حادثات الحياة ونوازلها ، وما بينها من
مراتب ، بحاجة إلى بصيرة نافذة في دقائق فقه الدين ، وفي فقه نوازل الحياة
، الذي هو أساس فقه التدين ، وبحاجة أيضاً إلى الحكمة البالغة ، وإخلاص
النصح في تحقيق ما اشتبه ، وتحرير ما اشتجر ، وذلك جهد بالغ لا يقوم به
إلا صفوة أهل العلم .
يقول الإمام ابن تيمية : (( اعتبار مقادر المصالح والمفاسد هو بميزان
الشريعة ، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص ، لم يعدل عنها ، وإلا اجتهد
برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر ، وقلّ أن تعوز النصوص من يكون خبيراً لها
وبدلالتها على الأحكام .
وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكرٍ ، بحيث
لا يفرقون بينهما ، بل إما أن يفعلوهما جميعاً ، أو يتركوهما
جميعاً ، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر ، بل ينظر ، فإن
كان المعروف أكثر ، أمر به ، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ، ولم ينه
عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ، بل يكون النهي حينئذ من باب الصدّ
عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله ، وزوال فعل الحسنات ..
وإن كان المنكر أغلب ، نهي عنه ، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ،
ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه ، أمراً بمنكر،
وسعياً في معصية الله ورسوله.
وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان ، لم يؤمر بهما ، ولم ينه عنهما ،
فتارة يصلح الأمر ، وتارة يصلح النهي ، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي ،
حيث كان المعروف والمنكر متلازمين ، وذلك في الأمور المعينة الواقعة ......
وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله .
ومن هذا الباب : إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن
أُبّي ، وأمثاله من أئمة النفاق والفجور ، لما لهم من أعوان ، فإزالة
منكره بنوع من عقابه ، مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك ، بغضب من قومه
وحميتهم ، وبنفور الناس إذا سمعوا أن (( محمدا )) يقتل أصحابه )) .
ومن ذلك حين قال عبد الله بن أُبي في غزاة سكع فيها رجل من المهاجرين
رجلاً من الأنصار فتناصرا : فعلوها ؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة
ليُخرجن الأعزُّ منها الأذلّ ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر
فقال : يا رسول الله ، دعني أضرب عنق هذا المنافق .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « دعه لا يتحدث الناس أنَّ محمدا يقتل
أصحابه » ( متفق عليه ) .
فتلك حكمة النبوة التي يجب أن يتأسى بها القائمون بتغيير المنكر ، ولهذا
قال (( عمر )) رضي الله عنه بعد أن استبان له نور الحكمة النبوية في هذا :
(( قد ـ والله ـ علمتُ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمُ بركة من
أمري )) .
ومن ثمَّ فإن تغيير المنكر المترتب على تغييره آثار فردية أو جماعية ، لا يستقيم القيام به إلا من بعد مراجعة ملابساته ومساقاته ، والموازنة بينه وبين آثاره ، وهذا يقتضي استشارة أهل العلم والحكمة ، فكثيراً ما يتوقف الطبيب عن معالجة داءٍ ما خشية ما سوف يترتب على معالجته دوائياً أو جراحياً من أدواء وآثار أفدح ، إلى أن تتهيأ الظروف والملابسات لمعالجته دونما آثار ضارة ، وكذلك مُغيِر المنكر يحتاج إلى الحكمة في هذا أكثر من احتياج الطبيب ، فإنَّ ما يترتب على غفلة الطبيب في هذا ، أقل ضرراً مما قد يترتب على غفلة المغيّر للمنكر .. ولا أحسب أن أحداً يتهم مثل ذلك الطبيب بالتقصير أو الخيانة أو الإفراط في القيام بواجبه حينئذ ، بل هو بوصف الحكيم النَّطاسيِّ : أجدرُ وأحقُّ .. وكذلك ينبغي ألا يتهم العامة والدهماء ، علماء الأمة حين يوصون بالصبر على ذلك المنكر ، حتى تتهيّأ له الظروف ومناخات وملابسات ومساقات أفضل ، يؤتي التغيير فيها ثمراً أطيب وأعظم ، وهذا وجه من وجوه المعنى القرآني في قوله تعالى : { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ } ( النحل : 125 ) ، وفي قوله تعالى : { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو
إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } (يوسف : 108 ) .
فالحكمة والبصيرة ، دعامتا النجاح في القيام بتغيير المنكر ، قياماً يرضي
الله عزَّ وعلا ، ويحقق الغاية من التكليف به .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .
والحمد لله رب العالمين .