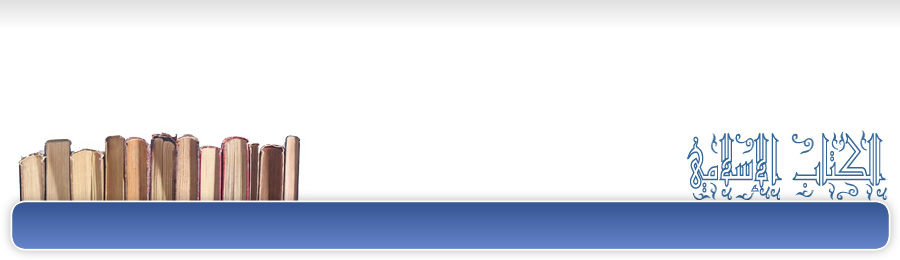كتاب : غاية المرام في علم الكلام
المؤلف : علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى زلزل بما أظهر من صنعته
أقدام الجاحدين واستزل بما أبان من حكمته ثبت المبطلين وأقوى قواعد
الإلحاد بما أبدى من الآي والبراهين واصطفى لصفوته من عباده عصابة
الموحدين ووثقهم من أسبابه بعروته الوثقى وحبله المتين فلم يزالوا للحق
ناظرين وبه ظاهرين ولله ولرسوله ناصرين وللباطل وأهله دامغين إلى أن فجر
فجر الإيمان وأشرق ضوؤه للعالمين وخسف قمر البهتان وأضحى كوكبه من الآفلين
ذلك صنع الذي أتقن كل شئ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
فنحمده على ما أولى من مننه وأسبغ من جزيل نعمه حمدا تكل عن حصره ألسنة
الحاصرين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبوئة لقائلها
جنة الفوز والعقبى في يوم الدين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى
الكافة أجمعين فأوضح بنوره سبل السالكين وشاد بهدايته أركان الدين صلى
الله عليه وعلى آله أجمعين وبعد
فإني لما تحققت أن العمر يتقاصر عن
نيل المقاصد والنهايات ويضيق عن تحصيل المطالب والغايات وتنبتر ببتره
أسباب الأمنيات وتفل بفله غر الهمم والعزمات مع استيلاء الفترة واستحكام
الغفلة وركون النفس إلى الأمل واستنادها إلى الفشل علمت أنه لا سبيل إلى
ذروة ذراها ولا وصول إلى أقصاها ولا مطمع في منتهاها فكان اللائق البحث
والفحص عن الأهم فالأهم والنظر في تحصيل ما الفائدة في تحصيله أعم
وأهم المطالب وأسنى المراتب من الأمور العملية والعلمية ما كان
محصلا
للسعادة الأبدية وكمالا للنفس الناطقة الإنسانية وهو اطلاعها على
المعلومات وإحاطتها بالمعقولاوت لما كانت المطلوبات متعددة والمعلومات
متكثرة وكل منها فهو عارض لموضوع علم يستفاد منه وتستنبط معرفته عنه كان
الواجب الجزم واللازم الحتم على كل ذي عزم البداية بتقديم النظر في الأشرف
الأجل والأسنى منها في الرتبة والمحل
وأشرف العلوم إنما هو العلم
الملقب بعلم الكلام الباحث عن ذات واجب الوجود وصفاته وأفعاله ومتعلقاته
إذ شرف كل علم إنما هو تابع لشرف موضوعه الباحث عن أحواله العارضة لذاته
ولا محالة أن شرف موضوع هذا العلم يزيد على شرف كل موضوع ويتقاصر عن حلول
ذراه كل موجود مصنوع إذ هو مبدأ الكائنات ومنشأ الحادثات وهو بذاته مستغن
عن الحقائق والذوات مبرأ في وجوده عن الاحتياج إلى العلل والمعلولات كيف
والعلم به أصل الشرائع والديانات ومرجع النواميس الدينيات ومستند صلاح
نظام المخلوقات
فلا جرم سرحت عنان النظر وأطلقت جواد الفكر في مسارح
ساحاته ومطارح غاياته وطرقت أبكار أسراره ووقفت منه على أغواره فلم تبق
غمة ألا ورفعتها ولا ظلمة إلا وقشعتها حتى تمهد سراحه واتسع براحه فكنت
بصدد جنى ثمراته والتلذذ بحلواته
ولم أزل على ذلك برهة من الزمن
مجانبا للإخوان إلى أن سألني من تعينت على إجابته وتحتمت على تلبيته أن
أجمع له مشكلات درره وأبين مغمصات غرره وأبوح بمطلقات فوائده وأكشف عن
أسرار فرائده
فاستخرت الله تعالى في أسعافه بطلبه واستعنته في قضاء
أربه فشرعت في تأليف هذا الكتاب وترتيب هذا العجاب وأودعته أبكار الأفكار
وضمنته غوامض الأسرار منبها على مواضع مواقع زلل المحققين رافعا بأطراف
استار عورات المبطلين كاشفا لظلمات تهويلات الملحدين كالمعتزلة وغيرهم من
طوائف الإلهيين على وجه لا يخرجه زيادة التطويل إلى الملل ولا فرط
الاختصار إلى النقص والخلل تسهيلا على طالبيه وتيسيرا على راغبيه وسميته
غاية المرام في علم الكلام وقد جعلته مشتملا على ثمانية قوانين وضمنتها
عدة مسائل قواعد الدين وهو المسئول أن يعصمنا فيما نحاوله من كل خلل وزلل
وأن يوفقنا لكل صواب من قول وعمل إنه على ما يشاء قدير وبإجابة الدعاء
جدير
القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
طريق إثبات الواجب
ذهب المحققون من الإسلاميين وغيرهم من أهل الشرائع الماضيين وطوائف
الإلهيين إلى القول بوجوب وجود موجود وجوده له لذاته غير مفتقر إلى ما
يسند وجوده إليه وكل ما سواه فوجوده متوقف في إبداعه عليه ولم نخالفهم في
ذلك إلا سواد لا يعرفون وطوائف مجهولون فلا بد من الفحص عن مطلع نظر
الفريقين والكشف عن منتهى أقدم الطائفتين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره
المشركون
ومبدأ النظر ومجال الفكر ينشأ من الحوادث الموجودة بعد
العدم فإن وجودها إما أن يكون لها لذاتها أو لغيرها لا جائز أن يكون لها
لذاتها وإلا لما كانت معدومة وإن كان لغيرها فالكلام فيها وإذ ذاك فإما أن
يقف الأمر على موجود هو مبدأ الكائنات ومنشأ الحادثات أو يتسلسل الأمر إلى
غير النهاية فإن قيل بالتسلسل فهو ممتنع
أما على الرأي الفلسفي
فلأنا إذا فرضنا ممكنات لا نهاية لأعدادها يستند بعضها إلى بعض في وجودها
وفرضنا بالتوهم نقصان عشرة منها مثلا فإما أن يكون عددها مع فرض النقصان
مساويا لعددها قبله أو أنقص أو أزيد لا جائز أن يكون مساويا إذ الناقص لا
يساوى الزائد فإن قيل أنه أزيد فهو أيضا ظاهر الإحالة وإن قيل أنها أنقص
فأحدهما
لا محالة أزيد من الآخر بأمر متناه وما زاد على المتناهى
بأمر متناه فهو متناه إذ لا بد أن يكون للزيادة نسبة إلى النامى بجهة ما
من جهات النسب على نحو زيادة المتناهى على المتناهى ومحال أن يحصل بين ما
ليسا متناهيين النسبة الواقعة بين المتناهيين لكن هذا مما لا يستقيم على
موجب عقائدهم وتحقيق قواعدهم حيث قضوا بأن كل ماله الترتيب الوضعي
كالأبعاد والامتدادات أو ترتيب طبيعىو آحاده موجودة معا كالعلل والمعلولات
فالقول بأن لا نهاية له مستحيل وأما ما سوى ذلك فالقول بأن لا نهاية له
غير مستحيل وسواء كانت آحاده موجودة معا كالنفوس بعد مفارقة الأبدان
والذوات أو هي على التعاقب والتجدد كالحركات فإن ما ذكروه وإن استمر لهم
فيما قضوا عليه بالنهاية فهو لازم لهم فيما قضوا عليه بأن لا نهاية وإذ
ذاك فلا يجدون عن الخلاص من فساد أحد الاعتقاديين سبيلا إما في صورة
الإلزام أو فيما ذكروه في معرض الدلالة والبرهان
وليس لما ذكره
الفيلسوف المتأخر من جهة الفرق بين القسمين قدح في الغرض هو قوله أن ما لا
ترتب له وضعا ولا آحاده موجودة معا وأن كان ترتبه طبعا لا سبيل إلى فرض
جواز قبوله الانطباق وفرض الزيادة والنقصان بخلاف نقيضه إذ المحصل يعلم أن
الاعتماد على هذا الخيال في تناهي ذوات الأوضاع وفيما له الترتيب الطبيعي
وآحاده موجودة معا ليس إلا من جهة إفضائه إلى وقوع الزيادة والنقصان بين
ما ليسا بمتناهيين وذلك إنما يمكن بفرض زيادة على ما فرض الوقوف عنده من
نقطة ما من البعد
المفروض أو وحدة ما من العدد المفروض وعند ذلك
فلا يخفى إمكان فرض الوقوف على جملة من أعداد الحركات أو النفوس الإنسانية
المفارقة لأبدانها وجواز الزيادة عليها بالتوهم مما هو من نوعها أو فرض
نقصان جملة منها وإذ ذاك فالحدود المستعلمة في القياس في محل الاستدلال هي
بعينها مستعلمة في محل الإلزام مع اتحاد الصورة القياسية من غير فرق
ثم إن فرض وقوع الزيادة والنقصان في محل النزاع وان كان جائزا ومع جوازه
واقعا فهو إنما يوجب النهاية في كل واحد من العددين أن لو كانت الزيادة
المتناهية التي فضل بها أحد العددين على الآخر لها نسبة إلى كل واحد منهما
نسبتها إلى ما هو متناه والخصم وإن سلم قبول المتناهى لنسبة ما هو
المتناهى إليه فقد لا يسلم قبول غير المتناهى لنسبة المتناهى إليه ولا
محالة أن بيان ذلك مما لا سبيل إليه كيف وأنه منتقض على الرأيين جمعا فإنه
ليس كل جملتين وقعت بينهما الزيادة بأمر متناه يكونان متناهيين فإن عقود
الحساب مثلا لا نهاية لأعدادها وإن كانت الأوائل اكثر من الثوانى والثوانى
اكثر من الثوالث بأمر متناه وهذه الأمور وان كانت تقديرية ذهنية فلا محالة
أن وضع القياس المذكور فيها على نحو وضعه في الأمور الموجودة في الفعل فلا
تتوهمن أن الفرق واقع من مجرد هذا الاختلاف
أما المتكلم فلعله قد
سلك في القول بوجوب النهاية ههنا ما سلكه الفيلسوف ولربما زاد عليه بقوله
لو فرض أعداد لا نهاية لها لم يخل إما أن تكون شفعا أو وترا أولا هي شفع
ولا وتر أو شفعا ووترا معا فإن كانت شفعا فهي تصير وترا بزيادة واحد وكذلك
إن كانت وترا فهي تصير شفعا بزيادة واحد وإعواز الواحد لما لا يتناهى محال
ولا جائز أن يكون شفعا ووترا أو لا شفع ولا وتر فإن ذلك ظاهر الإحالة وهذه
المحالات كلها إنما لزمت من فرض عدد لا يتناهى فهو أيضا محال وهو مع أنه
محض استبعاد الشفعية ما لا يتناهى أو وتريته إنما ينفع مع تسليم الخصم
لقبولية ما لا يتناهى أن يكون شفعا أو وترا وذلك مما لا سبيل إليه
ثم بم الاعتذار عن هذا الإلزام إن ورد على ما سلم كونه غير متناه
كالأعداد
من مراتب الحساب وكذلك ما يختص بمذهب المتكلم من اعتقاد عدم النهاية في
معلومات الله تعالى ومقدوراته
وما قيل من أن المعنى بكون المعلومات
والمقدورات غير متناهية صلاحية العلم لكل ما يصح أن يعلم وصلاحية القدرة
لتعلقها بكل ما يصح أن يوجد وما يصح أن يوجد ويصح أن يعلم غير متناه لكنه
من قبيل التقديرات الوهمية والتجويزات الخيالية وذلك مما لا يجب فيه القول
بالنهاية ولا كونه غير متناه مستحيل بل المستحيل إنما هو القول بأن لا
نهاية فيما له وجود عينى وهو في تعينه أمر حقيقى فلا أثر له في القدح فإن
من نظر بعين التحقيق وأمعن في التحديق علم أن هذه الأمور وإن كانت تقديرية
ومعاني تجويزية وأنه لا وجود لها في الأعيان فلا بد لها من تحقق وجود في
الأذهان ولا محالة أن نسبة ما فرض استعماله في القول بالنهاية فيما له
وجود ذهنى على نحو استعماله فيما له وجود عينى وأن ذلك بمجرده لا أثر لها
فيما يرجع إلى الافتراق أصلا
ومما يلتحق بهذا النظم في الفساد أيضا
قول القائل إن كل واحد من هذه الأعداد محصور بالوجود فالجملة محصورة
بالوجود وكل ما حصره الوجود فالقول بأن لا نهاية له محال فإن ما لا يتناهى
لا ينحصر بحاصر ما وهو إنما يلزم أن لو كان الحصر متناهيا ولا محالة أن
الكلام في تناهى الوجود كالكلام فيما يحصره الوجود هذا إن قيل بأن الوجود
زائد على الموجود وإلا فلا حاصر أصلا
ولربما نظر في العلل
والمعلولات إلى طرف الاستقبال فقيل ما من وقت نقدره إلا والعلل والمعلولات
منتهية بالنسبة إليه وانتهاء ما لا يتناهى محال وهو أيضا غير مفيد فإن
الخصم قد سلم انتهاء العدد من أحد الطرفين ومع ذلك يدعي أنه غير
متناه من
الطرف الآخر ومجرد الدعوى فيه غير مقبولة لا سيما مع ما قد ظهر من أن عقود
الحساب لا نهاية لها ولم يلزم من تناهيها من جهة البدء أن تكون متناهية من
جهة الآخر أو أن يوقف فيها على نهاية
فإذا الرأي الحق أن يقال لو
افتقر كل موجود في وجوب وجوده إلى غيره إلى غير نهاية فكل واحد بإعتبار
ذاته ممكن لا محالة فإن ما وجب وجوده لغيره فذاته لذاته إما أن تقتضى
الوجوب أو الامتناع أو الإمكان لا جائز أن يقال بالوجوب لأن عند فرض عدم
ذلك الغير إن بقي وجوب وجوده فهو واجب بنفسه وليس واجبا لغيره وإن لم يبق
وجوب وجوده فليس واجبا لذاته إذ الواجب لذاته ما لو فرض معدوما لزم منه
المحال لذاته لا لغيره ولا جائز أن يقال بالامتناع وإلا لما وجد ولا لغيره
فبقى أن يكون لذاته ممكنا
وإذا كان كل واحد من الموجودات المفروضة
ممكنا وهى غير متناهية فإما أن تكون متعاقبة أو معا فان كانت متعاقبة فما
من موجود نفرده بالنظر إلا وفرض وجوده متعذر وانتهاء النوبة إليه في
الوجود ممتنع فإنه مهما لم يفرض وجوب وجود فلا وجود له وكذا الكلام في
موجده بالنسبة إلى موجده وهلم جرا وما علق وجوده على وجود غيره قبله وذلك
الغير أيضا مشروط بوجود غيره قبله إلى ما لا يتناهى فإن وجوده محال
ونظير ذلك ما لو قال القائل لا أعطيك درهما الا وقبله درهما وكذا إلى ما
لا يتناهى
فإنه لا سبيل إلى إعطائه درهما ما وهو على نحو قول الخصم في
تناهى الأبعاد
باستحالة وجود بعدين غير متناهيين فرض أحدهما دائرا على الآخر بحيث يلاقيه
عند نقطة وينفصل عنه بأخرى بناء على أن ما من نقطة إلا وقبلها نقطة إلى ما
لا يتناهى فما من نقطة يفرض التلاقى عندها إلا ولا بد أن يكونا قد تلاقيا
قبلها عند نقطة أخرى إلى ما لا يتناهى وذلك محال كيف وأن ما من واحد يفرض
إلا وهو مسبوق بالعدم فالجملة مسبوقة بالعدم وكلى جملة مسبوقة بالعدم
ولوجودها أول تنتهى إليه فالقول بأن لا نهاية لأعدادها ممتنع
وما
يخص مذهب القائلين بالإيجاد بالعلية والذات أن كل واحد إما ان يكون موجدا
لما أوجده في حال وجوده أو بعد عدمه لا جائز أن يكون موجدا له بعد العدم
إذ العدم لا يستدعي الوجود وان كان موجودا له في حال وجوده فوجود المعلول
يلازم وجود علته في الوجود وهما معا فيه وإن كان لأحدهما تقدم بالعلية على
الآخر على نحو تقدم حركة اليد على حركة الخاتم ونحوه فإذا العلل
والمعلولات وإن تكثرت فوجودها لا يكون إلا معا من غير تقدم وتأخر بالزمان
و أما إن كانت معا فالنظر إلى الجملة غير النظر إلى الآحاد إذ حقيقة
الجملة غير حقيقة كل واحد من آحادها وان كان كذلك فالجملة إما أن تكون
بذاتها واجبة أو ممكنة لا جائز ان تكون واجبة وإلا لما كانت آحادها ممكنة
وان كانت ممكنة فهي لا محالة تفتقر إلى مرجح فالمرجح إما أن يكون خارجا عن
الجملة أو داخلا فيها لا جائز أن يكون من الجملة وإلا فهو مقوم لنفسه إذ
مقوم الجملة مقوم
لآحادها وذلك يفضى إلى تقوم الممكن بذاته وهو
متعذر إذ قد فرض كل واحد من آحاد الجملة ممكنا وإن كان خارجا عن الجملة
فهو إما واجب وإما ممكن فإن كان ممكنا فليس خارجا عن الجملة على ما وقع به
الفرض فبقى أن يكون واجبا بذاته لا محالة
فهو لا محالة واجب بذاته
وإلا لافتقر إلى غيره وذلك الغير إن كان خارجا عن الجملة المفروضة ففيه
إبطال الفرض وإن كان داخلا فيها ففيه توقف كل واحد على صاحبه وتقدمه
بالذات وكل واحد من القسمين متعذر فقد تنخل من الجملة أنه لا بد من القول
بوجوب وجود موجود وجوده لذاته لا لغيره
فإن قيل ما ذكرتموه فرع
إفضاء النظر إلى العلم وجعله مدركا وبم الرد على من أنكر ذلك ولم يسوغ غير
الحواس الظاهرة مدركا كيف وهو متعذر من جهة المطلوب ومن جهة المبدأ أما من
جهة المطلوب فهو أنه إما أن يكون معلوما أو مجهولا فان كان معلوما فلا
حاجة إلى طلبه إن كان مجهولا فتمتنع معرفته عند الظفر به
وأما من
جهة المبدأ فهو أن كل مطلوب فلا بد له عند التعريف من مبادئ معلومة سابقة
مناسبة وتلك المبادئ إما أن تكون بديهية أو مستندة إلى ما هو في نفسه
بديهي قطعا للتسلسل الممتنع والبديهي لا معنى له إلا ما يصدق العقل به من
غير توقف على أمر خارج عنه وهو ما لا حاصل له فإنه إما أن يكون حاصلا لنا
في مبدأ النشوء أو بعده لا جائز
أن يقال بالأول فإنا كنا لا نشعر
بها في مبدأ نشوئنا ولو كانت حاصلة لما وقع الذهول عنها إذ هو متناقض وإن
قيل بالثاني فإما يقال حصلت بالدليل أو بغير دليل فان كانت بالدليل فليست
بديهية وإن كانت من غير دليل فاختصاص حصولها بزمان دون زمان هو مما لا
حاصل له
وأما قولكم إن ما وجد بعد العدم لا بد وأن يكون وجوده لغيره
وإلا لما كان معدوما قبل فلو كان وجوده لغيره لم يخل إما أن يكون ذلك
الغير دائما علة أوحدث كونه علة فإن كان دائما علة وجب ألا يتأخر وجود
معلوله عن وجوده وأن لا يكون مسبوقا بالعدم وإن حدث كونه علة فالكلام في
تلك العلة كالكلام في معلولها وهلم جرا وهذا يؤدى إلى أن لا يكون معدوما
ولا مسبوقا بالعدم وهو محال أو إلى علل ومعلولات لا تتناهى ولم تقولوا به
وإنه لو افتقر الحادث في حال حدوثه إلى محدث لافتقر المعدوم في حال عدمه
إلى معدم وهو ممتنع لأن ما اقتضى العدم إما نفس ما اقتضى الوجود أو غيره
لا جائز أن يكون نفسه فإن ما اقتضى وجود شئ لا يقتضى عدمه وإن كان غيره
فذلك الغير إما واجب بذاته أو لغيره فإن كان واجبا بذاته أدى إلى اجتماع
واجبين وهو محال كما سيأتي كيف ويلزم أن يكون الشئ الواحد موجودا ومعدوما
معا لتحقق ما يقتضى كل واحد منهما وهو ممتنع وإن كان واجبا لغيره فذلك
الغير اما أن يكون هو نفس ما أوجب الحدوث أو غيره فإن كان نفسه فيستحيل أن
يوجب بذاته ما يقتضى عدم ما يقتضيه وجوده بذاته وإن كان غيره فيفضى إلى
اجتماع واجبين هو متعذر
وأيضا فإنه لو افتقر إلى موجد لم يخل إما أن
يكون موجدا له في حال وجوده أو في حال عدمه فإن كان موجدا له في حال وجوده
فهو محال إذ الموجود لا يوجد وإن كان موجدا له في حال عدمه فهو محال أيضا
ظاهر الإحالة ولو سلمنا أن ما وجد بعد العدم لا بد وأن يكون وجوده بغيره
لكن لا إفضاء له إلى أثبات واجب الوجود مع كون الخصم قائلا بعلل ومعلولات
إلى غير النهاية
وقولكم إنه لو كانت العلل والمعلولات غير
متناهية فكل واحد منها ممكن باعتبار ذاته فبم الرد على من إشترط في ممكن
الوجود أن لا يكون موجودا وأن الشئ مهما اتصف بالوجود فهو ضرورى الوجود
وضرورى الوجود لا يكون ممكنا فإن قيل له ممكن فبالاشتراك وليس هذا تسليم
المطلوب فإن كون الشئ ضرورى الوجود أعم من الضرورة الثابتة لذاته ومع
التسليم بكونها ممكنة فما ذكرتموه في أن لا نهاية غير مستقيم أما ما
ذكرتموه في طرف التعاقب فغير مطرد وذلك أنا لو فرضنا حادثا بعد العدم فإما
أن يقال إن له قبلا كان فيه معدوما أو ليس لا جائز أن يقال انه لم يكن له
قبل كان فيه معدوما وإلا لما كان له أول وهو خلاف الفرض وإن كان له قبل هو
فيه معدوم فذلك القبل إما موجود أو معدوم لا جائز أن يكون معدوما وإلا لما
كان له قبل إذ لا فرق بين قولنا إنه لا قبل له وبين قولنا إن قبله معدوم
فبقى أن يكون موجودا ثم ما قبل يفرض إلا وهو مسبوق بقبل آخر إلى ما لا
نهاية له على هذا النحو فإذا قد ثبت وجودات لا نهاية لأعدادها وإن كانت
متعاقبة وكل واحد مسبوق بعدمه وبه تبين كذب ما ذكرتموه من القياس وأما
معتمد القائلين بالإيجاد بالعلية فطريق الرد عليهم ما هو طريق لكم في الرد
عليهم كما يأتي فيما بعده
وأما ما ذكرتوه في طرف المعية ووجوب
الانتهاء فيها إلى موجود وجوده لذاته فذلك الموجود لا يخلو إما أن يكون
ممكنا أو ليس بممكن فإن كان ممكنا فهو من الجملة وليس بواجب وإن لم يكن
ممكنا فما ليس بممكن ليس بواجب وبهذا يندفع ما ذكرتموه في جانب الانتهاء
إلى موجود هو مبدأ الموجودات أيضا
والجواب أما طريق إفحام المنكر
لكون النظر مدركا أن يقال نفى إفضاء النظر إلى العلم إما معلوم أو غير
معلوم فإن كان معلوما فإما أن يكون حصوله متوقفا على مدرك يعلم به أو ليس
فإن كان متوقفا فالمدرك إذا إما الحواس أو النظر لا جائز أن يكون مدركه
الحواس إذ هو غير محسوس فتعين أن يكون مدركه النظر وإن لم يكن متوقفا على
مدرك فهو بديهي ولو كان بديهيا لما وقع الاختصاص به لطائفة دون طائفة كيف
وأنه لو خلى الانسان ودواعى نفسه في مبدأ نشوئه مع قطع النظر عن النظر لم
يجد في نفسه الجزم بذلك أصلا وكل ما ليس على هذه القضية من العلوم فليس
ببديهي وإن اكتفى في ذلك بمجرد الدعوى فقد لا تؤمن المعارضة بمثله في طرف
النقيض وليس عنه محيص
وأما إن كان مجهولا غير معلوم فالجزم بنفيه
متعذر لعدم الدليل المفضى إليه وليس هذا مما ينقاس في طرف النقيض فإن من
حصلت عنده المواد الصادقة المقترنة بالصور الحقة التي يتولى بيانها
المنطقى لم يجد في نفسه جحد ما يلزم عنها وذلك كعلمنا بأن الأربعة زوج
لعلمنا بأنها منقسمة بمتساويين وكل منقسم بمتساويين فهو زوج كيف وأنا نجد
من أنفسنا العلم بأمور كلية حصلت لنا بعد ما لم تكن ولو خلينا على أصل
الفطرة من غير طلب لها لم نعلمها فلا بد لها من مدرك موصل
إليها فإنها غير بديهية وليس المدرك هو الحواس إذ الكليات غير
محسوسة فتعين أن يكون النظر ولولا أنه صحيح لما أفضى إلى المطلوب
فإن قيل ما ذكرتموه في معرض إثبات النظر غير بديهي وإلا وقع اختصاصكم به
دوننا فبقى إن يكون نظريا وفيه إثبات النظر بالنظر وهو ممتنع
فالواجب أن يقال ما ذكرتموه في معرض الإبطال إما أن يكون صحيحا أو فاسدا
فإن كان صحيحا فقد أبطلتم النظر بالنظر أيضا وهو ممتنع وإن كان فاسدا فلا
حاجة إلى الجواب
وقولهم إن المطلوب في النظر إن كان معلوما فلا حاجة إلى طلبه وإن كان
مجهولا فلا فائدة لطلبه لعدم الوقوف عليه عند الظفر به
قلنا الشئ قد يكون معلوما من وجه ومجهولا من وجه أعنى معلوما بالقوة
ومجهولا بالفعل وذلك إنما يكون عند كون الانسان عالما بقضيه كلية وهو جاهل
بما يدخل تحتها بالجزئية أو عالم به لكنه غافل عن الارتباط الواقع بينهما
مثال الأول علمنا بأن كل اثنين زوج وجهلنا بزوجية ما في يد زيد مثلا
لجهلنا باثنينيته لكن جهلنا به إنما هو جهل بالفعل وإن كان معلوما بالقوة
من جهة علمنا بأن كل اثنين زوج
ومثال الثاني ظن كون البغلة المنتفخة
البطن حبلى مع العلم بأنها بغلة وأن كل بغلة عقيم فالعلم بكونها عقيما
واقع بالقوة والجهل بذلك إنما هو بالفعل فمستند الجهل في المثال الأول
إنما هو عدم العلم بالمقدمة الجزئية وفي الثاني الغفلة عن الارتباط بين
المقدمتين فالطلب إذا إنما هو المثل هذا المجهول فإنه مهما ظفر به وعرفه
بالفعل
على الصفات التي كانت معلومة بالقوة عرف أنه مطلوبه لا محالة
أما أن يكون الطلب لما علم أو جهل مطلقا فلا
وأما القضايا البديهية فهي كل قضية يصدق العقل بها عند التعقل لمفرداتها
من غير توقف على مبدأ غيرها فعلى هذا حصولها لنا في مبدأ النشوء إنما هو
بالقوة لا بالفعل وعدم حصولها بالفعل إنما كان لعدم حصول مفرداتها التي لا
تحصل إلا بكمال آلة الإدراك فإذا حصلت المفردات عند كمال آلة الادراك بادر
العقل إذ ذاك بالنسبة الواجبة لها من غير توقف اصلا فعلى هذا لم يلزم من
عدم حصولها لنا فى مبدأ النشوء بالفعل ان تكون غير بديهية ولا من تأخرها
أن تكون نظرية فبطل ما تخيلوه
وأما ما ذكروه في امتناع افتقار
الحادث إلى المحدث فإنما يلزم أن لو لم يكن مستنده القصد والإرادة بل
الطبع والعلة وليس كذلك أما على الرأي الفلسفي القائل بالايجاد بالعلية
فهو أن الافلاك متحركة على الدوام لتحصيل ما لها من الأوضاع الممكنة لها
على وجه التعاقب والتجدد طلبا للتشبه بمعشوقها والالتحاق بمطلوبها مقتضية
للحركات الدورية بإرادات قديمة لأنفس الأجرام الفلكية وبتوسط الحركات وجدت
التأثيرات كالامتزاجات والاعتدالات وغير ذلك من الأمور السفليات وقبول
القابليات للصور الجوهرية والأنفس الإنسانية فإن ما لم يوجد منها إنما هو
لعدم القابلية لا لعدم الفاعلية إذ الفاعل إنما هو العقل الفعال الموجود
مع جرم فلك القمر
وأما الرأي الإسلامي فمصدر الحوادث بأسرها
ومستندها إنما هو صانع مريد مختار اقتضى بإرادة قديمة وأنشأ بمشيئة أزلية
كل واحد منها في الوقت الذي اقتضى وجوده فيه كما يأتي تحقيقه فيما بعد إن
شاء الله تعالى
فليس الموجد للحوادث محدثا حتى يفتقر إلى محدث ولا هو موجد لها إيجادا
بالعلية أو الطبع حتى يلزم قدم ما صدر عنه بقدمه
وقولهم لو افتقر الحادث في حال وجوده إلى محدث لافتقر في حال عدمه الى
معدم قلنا مهما كان الشئ في نفسه ممكنا فلا بد له من مرجح لأحد طرفيه أعنى
الوجود والعدم وإلا فهو واجب أو ممتنع فكما أنه في حال وجوده يفتقر إلى
مرجح فكذا في جانب عدمه والمرجح للعدم هو المرجح للوجود لكن إن كان مرجحا
بالذات عند القائلين به فعدمه هو المرجح للعدم لا نفس وجوده وأما عند
القائلين بالإرادة فيصح أن يقال عدم المعدوم في حال عدمه مستند إلى عدم
تعلق القدرة بإيجاده والإرادة بتخصيصه في ذلك الوقت ولا يلزم من ضرورة
وجود القدرة والإدارة في القدم قدم ما يتخصص بها كما سنبينه فيما بعد
ويحتمل أن يقال بإسناده إلى قدرة قديمة اقتضت عدمه وإرادة أزليه اقتضت
تخصيص عدمه بذلك الوقت كما اقتضت تخصيص وجوده بوقت آخر والمرجح للطرفين
واحد لا تعدد فيه وإن وقع التعدد في متعلقة كما سيأتي بعد
وأما ما
ذكروه من امتناع إحداث المحدث في حالي الوجود والعدم فلا يستقيم وذلك أن
ما وجد بعد العدم إما أن يكون وجوده لذاته أو لغيره لا جائز أن يكون
وجوده لذاته وإلا لما كان معدوما فبقي أن يكون وجوده لغيره كما
قررنا
والإقتضاء لوجوده ليس هو له في حال عدمه وإلا لما كان معدوما فليس
الاقتضاء لوجوده إلا في حال وجوده لا بمعنى أنه أوجده بعد وجوده بل معنى
اته لولا المرجح لما كان موجودا في الحالة التى فرض كونه موجودا فيها وعند
ذلك فلا التفات إلى من اعتاص هذا القدر على فهمه واعترضت عقله مرامى وهمه
وأما اشتراط انتفاء الوجود عن ممكن الوجود فيعتذر جدا وذلك أن ممكن الوجود
هو بعينه ممكن العدم فإن اشترط في ممكن الوجود أن لا يكون موجودا فليشترط
في ممكن العدم أن لا يكون معدوما فإنه كما أن الخروج الى الوجود يخرجه إلى
ضرورة الوجود فالخروج إلى العدم يخرجه إلى ضرورة العدم وذلك يفضى إلى أن
لا يكون الممكن موجودا ولا معدوما وهو محال
فإن قيل إن العدم لا يخرجه إلى ضرورة الوجود بالمعنى المشروط دون المطلق
فهو صحيح لكن لا منافاة بينه وبين الممكن
وأما ما ذكروه من القبليات الغير المتناهية فمندفع وذلك أنهم إن فسروا
القبلية بأمر زائد على عدمه كان عدمه فيها فغير مسلم بل لا معنى لقبلية
الشئ إلا أنه لم يكن فكان ومع هذا التفسير للقبلية فلا يتمهد ما ذكروه كيف
وأنه يستحيل القول بما ذكروه نظرا إلى ما أشرنا إليه من البرهان وأوضحناه
من البيان في عدم حوادث لا تتناهى
وأما ما ذكروه في بيان استحالة القول بوجوب واجب الوجود نظرا إلى ثبوت
الإمكان
له ونفيه عنه فمنشأ الغلط فيه إنما هو من اشتراك لفظ الممكن إذ
قد يطلق
على ما ليس بممتنع وعلى ما لا ضرورة في وجوده ولا في عدمه فالاعتبار الأول
أعم من الواجب بذاته والثاني مباين له فعلى هذا إن قضى عليه بكونه ممكنا
فليس إلا بالاعتبار الأول ولا يلزم منه نفى الوجوب لكونه أعم منه وإن سلب
عنه الإمكان فليس إلا بالاعتبار الثانى و لا يلزم منه نفى الوجوب ايضا بل
ربيما كان الوجوب هو المعتبر او الأمتناع لا محالة نعم لو سلب عنه الإمكان
بالاعتبار الأول أو أثبت له بالاعتبار الثاني لزم ألا يكون واجبا فقد تقرر
كما أشرنا إليه أنه لا بد من القول بوجوب وجود موجود وجوده لذاته لا لغيره
24
وهو حسبي ونعم الوكيل
القانون الثاني في إثبات الصفات وابطال تعطيل من ذهب إلى نفيها من أهل
المقالات ويشتمل على قاعدتين26
القاعدة الاولى
في مسأله الأحوال
وهو أنه لما كان النظر في الصفات النفسية قد تعلق نوعا من التعلق بالنظر في الصفات الحالية ولربما توصل بعض المتكلمين من الأصحاب والمعتزلة منها إلى إثبات الصفات النفسية فلا جرم وجب أن يقدم النظر في بيان الأحوال اولا فنقولذهب أبو هاشم إلى القول بإثبات الأحوال ووافقه على ذلك جماعة من المعتزلة والكرامية وجماعة من أصحابنا كالقاضى أبي بكر والإمام أبي المعالي ونفاها من عدا هؤلاء من المتكلمين
وقبل النظر في تحقيق مذهب كل فريق يجب أن نعرف الحال ومعناها ليكون التوارد بالنفى والإثبات على محز واحد من جهة واحدة ثم التعريف بماذا
قال بعض المتكلمين ليس إلا بذكر أقسامها ومراتبها لا بالحد والرسم إذ الحد
والرسم لا بد وأن يكون متناولا لجميع مجارى الأحوال وإلا فهو أخص منها
والحد والرسم يجب أن يكونا مساويين للمحدود لا أخص منه ولا أعم وإلا يفضى
إلى ثبوت الحال اللحال من جهة أن الحد لا يتناولها إلا وقد اشتركت كلها في
معنى واحد وكب ما وقع به الاشتراك والافتراق من الذوات والمعاني فهو حال
زائد عليها لكن هذا القائل إما أن يفرق بين ما به تتفق الذوات وتفترق وبين
ما به تتفق الأحوال وتفترق على ما يقوله القائل بالأحوال فإن عنده الذوات
هي التي تتفق وتفترق بالأحوال أما اتفاق الأحوال وافتراقها ليس إلا
بذواتها كما يأتي أو أنه لا يعترف بالفرق فإن اعترف فلا اتجاه لما ذكره
وإن لم يعترف بالفرق فليس ما أبطله بأولى مما عينه فإنه كما يتعذر التعريف
بالحد لما فيه من إثبات الحال للحال كذا يمتنع التعريف بما ذكره إذ في
ضرورة الاعتراف بالأنقسام وقوع ما به الانقسام وإن ما أشار إليه أشعر بجهل
صناعة الحدود والرسوم
وذلك أن ما ذكروه وإن اتجه في الحدود التي لا
يستعمل فيها غير الذاتيات فهو غير متجه في الرسوم من جهة ان المقصود من
الرسم ليس إلا تمييز الشئ عما سواه تمييزا غير ذاتي والتمييز كما يحصل
بالخواص والوجودية الثابتة للشئ المرسوم دون غيره كذلك قد يحصل بالسلوب
المختصة به دون غيره وإذ ذاك فلا يلزم ثبوت الحال إذا ما عرفت بها إذ
الحال صفة إضافية والسلب المحض ليس بثبوتي فعلى هذا إن عرفت الحال بأمر
سلبى وخاص عدمى كان التعريف صحيحا ولم يكن ما ذكروه متجها وذلك ممكن لا
محالة فإنه لا مانع من أن يقال الحال عبارة عن صفة إثباتية لموجود غير
متصفة بالوجود ولا بالعدم فإن ما تخيل كونه صفة زائدة على المرسوم ليس إلا
أمرا سلبيا ومعنى عدميا وهو سلب الوجود والعدم
وأما ما سوى ذلك
فليس بزائد على نفس المرسوم ولا هو كالصفة له أصلا وهو على نحو قولنا في
واجب الوجود انه الوجود الذي لا يفتقر إلى غيره في وجوده فإن ما به
التمييز ليس إلا سلب الافتقار إلى الغير لا غير وأما مدلول اسم الوجود
فإنه لا يستدعي من جهة اخذه في الرسم أن يكون صفة داخلة في المرسوم و لا
زائدة عليه خارجة عن معناه بل لو كان هو نفس الذات المرسومه كان الرسم
بالنظر الى الصناعة الرسمية صحيحا
وعند هذا فلا بد من الإشارة إلى أقسامها وهي تنقسم إلى معللة وإلى غير
معللة
فأما المعللة منها فهي كل حكم يثبت للذات بسب معنى قام بالذات ككون العالم
عالما والقادر قادرا ونحوه وقد زاد أبو هاشم ومن تابعه من المعتزله في ذلك
اشتراط الحياة فعلى مذهبه إيجاب الأحوال المعللة ليس إلا للصفات التي من
شرطها الحياة كالعلم والقدرة ونحوه وأما ما لا تشترط فيه الحياة من الصفات
فلا وذلك كالسواد والبياض ونحوه والمستند له في الفرق أن ما من شرطه
الحياة كالعلم ونحوه أنما يتوصل إلى معرفته من معرفة كون ما قام به عالما
ولا كذلك السواد والبياض فإنه مشاهد مرئى فلا يفتقر إلى الاستدلال عليه
بكون ما قام به أسود وأبيض فلهذا جعل علة ثم ولم يجعل علة ههنا
والمحقق يعلم أن التوصل إلى معرفة وجود الشئ من حكمه أو ما يلزم من الآثار
إنما هو فرع كونه مؤثرا له وملزوما فإذا يجب جعله عله من ضرورة معنى لا
يتم إلا بالنظر إلى عليته ثم إن الحركة قد تكون طبيعية وليس من شرطها
الحياة وقد تكون إرادية من شرطها الحياة ولا محالة أن نسبة الحركة
الطبيعية إلى كون المحل متحركا كنسبة الحركة الإرادية إلى كون المحل
متحركا فيما يرجع إلى المعرفة والخفاء ومع
هذا فقد جعلوا الحركة الإرادية علة كون المحل متحركا ولا كذلك
الحركة الطبيعية فهل الفرق إلا تحكم
فإذا قد بان أنه لا وجه للفرق وهو الرأي الحق وإليه ذهب القائلون بالأحوال
من أصحابنا هذا تمام الكلام في القسم الأول
وأما الحال غير المعللة
فهي كل صفة ثبتت للذات غير معلله بصفة زائدة عليها كالوجود واللونية
ونحوها فهذه أقسام الأحوال
وهل هي عند من أثبتها معلومة بإنفرادها أو مع غيرها
قال أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة إنها لا تعلم إلا مع الذوات من حيث إن
العلم إنما يتعلق بطريق الإستقلال عندهم بما هو في نفسه ذات والذوات ثابتة
في العدم والأحوال متجددة
وأما من قال بها من أصحابنا فإنه لم يمنع
من تعلق العلم بها على انفرادها ولعل مستند الاختلاف في الاشتراط وعدمه
إنما هو بالنظر إلى الحقيقة والثبوت فرب من وقف تعلق العلم لها على الذوات
نظر إلى جهة الثبوت والآخر إلى جهة الحقيقة إذ هي غير إضافية وكل منهما إذ
ذاك مصيب فيما يقول أما إن كان توارد النفي والإثبات على جهة واحدة من
هاتين الجهتين فلا محالة أن المثبت لهذا الاشتراط يكون مصيبا بالنظر إلى
الثبوت مخطئا بالنظر إلى الحقيقة والثاني بعكسه
وإذا عرف معنى الحال
وأقسامها فيجب أن نعود إلى المقصود وهو الكشف عن مأخذ الفريقين والتنبيه
على معتمد الطائفتين وقد اعتمد مثبتو الأحوال على الدلالة والإلزام
أما الدلالة فهو أنهم قالوا الذوات المختلفة كالسواد والبياض مثل
لا محالة
أنهما متفقان في شئ وهو اللونية ومختلفان في شئ وهو السوادية والبياضية
وليس ما به وقع الاتفاق هو ما به وقع الاختلاف وإلا كان شيئا واحدا فإذا
هما غيران وهو المقصود
وأما ما اعتمدوه إلزاما فهو أنهم قالوا القول
بإنكار الأحوال يفضى إلى إنكار القول بالحدود والبراهين وأن لا يتوصل أحد
من معلوم إلى مجهول ولا سيما صفات الرب تعالى إذ منشأ القول بها ليس إلا
قياس الغائب على الشاهد وهذا كله محال
ومما اعتمدوا عليه وهو محض
الأحوال المعللة أن قالوا نحن نعقل الذات ثم نعقل كونها متحركة بعد ذلك
وليس ذلك إلا حالا زائدا عليها وليس ذلك هو نفس الحركة فإنا نعقل المتحرك
ونجهل قيام الحركة به ولو كان المتحرك وقيام الحركة بالمحل شيئا واحدا
لاستحال أن تكون معلومة مجهولة معا
والجواب أما ما ذكروه من الشبهة
الاولى فالكلام فيها على ما به الاشتراك والاختلاف يستدعى تفصيلا فنقول
قولهم إن السواد والبياض يشتركان في اللونية فإما أن يراد به الاشتراك في
التسمية أي أنه يطلق على كل واحد منهما أنه لون أو الاشتراك في مسمى
اللونيه فإن أريد به الأول فهو خلاف أصلهم ومع ذلك فإن الاسماء لا تكون
صفات للذوات ثم إن اريد به الثاني فمسمى اللونية لا محالة ينقسم إلى كلى
أي صالح أن يشترك فيه كثيرون وإلى مشخص أي ليس له صلاحية أن يشترك فيه
كثيرون فالأول مثل اللونية الموجودة في الأذهان وتلك لا تحقق لها في
الأعيان والثاني كهذا اللون وكذا كل ما يصح أن يشار إليه بسبب الإشارة إلى
موضوعه فعلى هذا إن أريد به اللونية المشخصة فإما
أن يقال إن ما
ثبت للسواد من اللونية بعينها ثابتة للبياض أو إن ما تخصص بكل واحد منهما
غير الآخر لا حائز أن يقال بالأول كما ذهب إليه مثبتو الأحوال إذ يلزم منه
أن يتعدد المتحد أو يتحد المتعدد وكلا الأمرين محال وإن قيل بالثاني فليس
ذلك بحال ولا صفة زائدة على ذات السواد من حيث هو سواد بل هو داخل في
الذات والحقيقة ولهذا إن من أراد تعقل السواد لم يمكنه أن يتعقله ما لم
يكن قد عقل اللونية أولا وما لا تتم الذات إلا به وهو مقوم لها كيف يكون
زائدا عليها
ثم كيف يكون لا موجودا ولا معدوما وهو مقوم للموجود
والموجود لا يتقوم إلا بموجود ثم ولو قدر كونه زائدا فالذوات إما أن تكون
متماثلة دونه أو متمايزة فإن كانت متماثلة فتماثلها إن لم يكن بأنفسها
فبزائد وذلك يفضى إلى التسلسل من جهة ان الكلام فيما وقع به التماثل ثانيا
كما في الأول وهو ممتنع وإن كانت متمايزة فذلك أيضا إما لأنفسها أو بخارج
عنها وكلاهما يجر إلى إبطال الحال أما الأول فظاهر وأما الثاني فمن جهة أن
الذوات إما أن تكون متماثلة دونه أو متمايزة والكلام الأول بعينه عائد وهو
محال وإن أريد به اللونية العقلية المطلقة فتلك لا يتصور ان تكون صفة لما
يتشخص من الذوات ومعنى دخول جميع الشخصيات تحتها ليس إلا أن ما حصل في
الذهن من معنى اللونية مطابق لما يحصل من معنى أي لون كان من أشخاص اللون
من غير زيادة ولا نقصان وعند هذا إن أريد باشتراك اللونية بين السواد
والبياض هذا النحو من الاشتراك فلا إنكار بل هو الرأي الحق ولا مشاحة فيه
وعند هذا فليس لقائل أن يقول من نفاة الأحوال إن الاشتراك بين السواد
والبياض ليس إلا في مجرد التسمية فإنا نحن ندرك الاشتراك في الجملة وان
قطعنا النظر عن التسميات والعبارات ونشعر بالاشتراك وإن طاحت الاصطلاحات
والإطلاقات فليس ذلك الا بالنظر إلى قضية عقلية وصورة معنوية كيف وأنا
نعقل حقيقة الإنسان
مطلقة ونعقلها شخصة وليس تعقلها تعقلا كليا
هو نفس تعقلها تعقلا شخصيا ولهذا لو مات جميع أشخاص الإنسان الموجودة في
الأعيان لم تبطل الحقيقة المطلقة الموجودة في الأذهان
ثم لو قيل
بذلك للزم منه إبطال القول بالحد والبرهان وأن لا يتوصل إحد من معلوم إلى
مجهول وذلك أن الأشياء إما كلية وإما شخصية على ما عرف بالقسمة الحاصرة
والحد والبرهان ليس إلا للأمور الكلية دون الشخصية وذلك لأن الحد والبرهان
ليسا من الأمور الظنية التخمينية بل من اليقينية القطعية والامر الشخصى
ماله من الصفات ليست يقينية بل هي على التغير والتبدل على الدوام فلا يمكن
أن يمكن أن يؤخذ منه ما هو في نفسه حقيقى يقينى وهذا بخلاف الأمور الكلية
فعلى هذا قد بان أن من أراد بإطلاق الحال على ما يقع به الاشتراك النحو
الذي أشرنا إليه كان محقا لكن لا ينبغى أن يقال إنها ليست موجودة ولا
معدومة بل الواجب أن يقال إنها موجودة في الأذهان معدومة في الأعيان وأما
من أراد به غير ما ذكرناه كان زائغا عن نهج السداد حائدا عن مسلك الرشاد
وأما الكلام على ما به يكون الافتراق فهو أن يقال ما به وقع الافتراق بين
السواد والبياض إما أن يكون في مجرد التسمية كما في قولنا سوادية وبياضية
وإما في مدلولهما لا سبيل إلى الاول كما ذهب إليه نفاة الاحوال فإنا لو
قطعنا النظر عن التسمية كما أشرنا إليه في جانب الاشتراك لقد كنا ندرك
الافتراق لا محالة فليس هو إذا إلا في قضية عقلية معنوية
وإن كان
الافتراق بنفس مدلول لفظ السوادية والبياضية فإما أن يكون ذلك هو نفس
الذات المتميزة او حاصلا فيها أو خارجا عنها فإن كان الاول فالتمايز بين
الذوات ليس إلا لأنفسها لا لأمور زائدة عليها وكذلك إن كان القسم الثاني
أيضا وإن كان القسم الثالث فكيف يصح القول بأن كل ما وقع به
الافتراق بين
ذاتين فهو زائد عليها خارج عنها والعقل الصحيح يقضى بان الافتراق بين بعض
الذوات قد يكون بأمور لا يتم تعقل تلك الذوات إلا بعد تعقلها أولا وذلك
كما وقع به الافتراق بين الإنسان والفرس والجوهر والعرض وغير ذلك من
الانواع والأجناس المختلفة وإذ ذاك فلا يكون ما وقع به الافتراق خارجا ولا
حالا زائدا كيف وأنه إما أن تكون تلك الذوات متمايزة دونه أو غير متمايزة
فإن كانت متمايزة فمن ضرورة تمايزها وقوع ما به التميز فإن كان ذلك أيضا
حالا زائدا على الذات فالكلام فيه كالكلام في الأول وذلك يفضى إلى ما لا
يتناهى وهو محال وإن لم تكن متمايزة دونه فهى لا محالة متماثلة ومشتركة
وما به التماثل والاشتراك على ما عرف من اصل القائل بالأحوال حال زائد على
المتماثلات فعند هذا إما أن يكون التماثل فيما هو زائد على الذوات أو في
نفس الذوات فإن كان في زائد على نفس الذوات فلا بد أن تكون لا محالة
متمايزة والكلام الاول بعينه لازم إلى غير النهاية وإن كان ليس في زائد
على نفس الذوات لزم أن لا يكون ما به التماثل حالا أو أن تكون الذوات
بأسرها أحوالا وهو خروج عن المعقول وإبطال لتحقيق الأحوال أيضا إذ الأحوال
من الصفات التي لا قوام لها بأنفسها دون ذوات تضاف إليها على ما عرف من
مذهب القائل بالأحوال
ثم إنه لو كان ما به يقع الاتفاق والافتراق
بين الذوات حالا فلا محالة أن بين الاحوال اتفاقا وافتراقا إذ ليس كلها
حالا واحدة وعند ذلك فما يلزم في الذوات من الاتفاق والافتراق بعينه لازم
في الاحوال وذلك يفضي إلى إثبات الحال للحال وذلك عندهم محال
فإن
قيل إنما لم تثبت الأحوال للأحوال من جهة أن الاحوال صفات والصفات لا تثبت
للصفات بخلاف الذوات وأيضا فإن ذلك مما يفضى إلى ثبوت الحال للحال إلى غير
النهاية وهو محال وليس يلزم من كون الاتفاق والافتراق بين الذوات لا يقع
إلا بالحال أن يكون الاتفاق والافتراق بين الاحوال بالأحوال وهذا كما نقول
في حقائق الأنواع كالإنسان والفرس ونحوه فإنها تشترك في الأجناس وتفترق
بالفصول ولم يلزم أن تكون للأجناس وإن تعددت جنس فإن الجوهر والكم والكيف
أجناس وما وقع به الاشتراك بينهما من الوجود ونحو فليس بجنس لها وكذا لم
يلزم أن تكون للفصول وإن تعددت فصول والا أفضى إلى التسلسل وهو محال فكما
قيل في الأجناس والفصول فلنقل مثله في الاحوال كيف وإن ما ذكرتموه من
الإشكال راجع عليكم بالمناقضة والإلزام فإنكم رمتم به نفى الأحوال بطريق
العموم والشمول وذلك مع قطع النظر عن معنى يعم محال وهو بعينه اعتراف
بالحال
فالجواب أما ما ذكروه من امتناع قيام الصفات بالصفات فهو
يرجع عليهم بالإبطال حيث أثبتوا الأحوال للأعراض وهي صفات ولم يتأبوا عن
ذلك فإذن ما ذكروا من الفرق لا معنى له وأما منع قيام الحال بالحال قطعا
للتسلسل فليس هذا بأولى من إبطال الاحوال أصلا ورأسا قطعا للتسلسل وهو
أولى منعا للتحكم والتهجم بمجرد الدعوى من غير دليل
وقولهم إن
الأجناس تماثل بها الأنواع وما تتماثل به الأجناس لا يلزم أن يكون جنسا
فهو غلط فإن ما تماثلت به الأنواع لم يكن جنسا من حيث عمومه لها فقط فإن
الإنسان والفرس قد يشتركان مثلا في السواد والبياض ولا يقال إنه جنس لهما
فإذا الجنس هو ما تتماثل به الانواع ويقال عليها قولا أوليا في جواب ما هو
وذلك كالحيوان
بالنسبة إلى الإنسان والفرس فعلى هذا إنما لم يكن
ما وقع به الاشتراك بين الجوهر والعرض من الوجود وغيره جنسا لهما من حيث
إنه لم يكن مقولا عليهما على النحو الذي ذكرناه ولهذا يفهم كل منهما دونه
ولو كان الجنس هو ما تتماثل به الحقائق المختلفة في الجملة لقد قلنا إن ما
اشترك فيه الجوهر والعرض جنس لهما لكن لم يكن الامر هكذا وهذا بخلاف
الاحوال فإنها إنما كانت احوالا من حيث إنه وقع بها الاتفاق والإفتراق
وذلك بعينه متحقق في الأحوال وإن كان اسم الحال لا يطلق إلا على ما به
الاتفاق والافتراق بين الذوات فهو نزاع في التسمية لا في المعنى
وأما القول بأن الأنواع تتميز بالفصول وتمييز الفصول لا يكون بالفصول
فنقول إذا وقع الافتراق بالفصول فإما أن يقال هي نفس الاحوال أو الأحوال
زائدة عليها فإن قيل إنها نفس الاحوال التي بها يكون تميز الأشياء بعضها
عن بعض فهو محال إذ الفصول داخلة في الحقائق أي لا تعقل حقائق الأنواع إلا
بتعقلها اولا وما لا يعقل الشئ إلا بتعقله أولا فلا يكون صفة زائدة على
الحقيقة على ما قررناه ومع كونه محالا فلم يتوصلوا إلى المطلوب إلا
بتعيينه وهو ممتنع وإن قيل إن الاحوال غير الفصول وإنها زائدة عليها فلا
محالة أنه قد حصل التمييز بين الأشياء بالفصول لا بالأحوال
وأما ما
ذكروه في معرض الإلزام آخرا فإنما يلزم القائل من نفاة الاحوال إن التماثل
بين الذوات ليس إلا في مجرد الأسماء فقط أما على رأينا فلا وبهذا يندفع
قولهم إن إنكار الاحوال يفضى إلى حسم باب القول بالحد والبرهان
وأما
ما ذكروه من شبهة المتحرك والحركة وقولهم إنا نعلم وجود الذات ثم نعلم
كونها متحركة أو عالمة او قادرة إلى غير ذلك فهو وإن كان صحيحا فالقول بأن
علمنا بكون
الذات متحركة أو عالمة او قادرة غير قيام الحركة بها
العلم والقدرة بها هو موضع الخيال ومحز الإشكال بل ليس كون الشئ متحركا
يزيد على قيام الحركة به و لا كونه عالما يزيد على قيام العلم به وكذلك في
سائر إحكام الصفات فإذا ما ذكروه ليس إلا مجرد استرسال بدعوى ما وقع
الخلاف فيه وهو غير معقول
وإذا تحقق ما ذكرناه وتقرر ما مهدناه علم
منه القول بنفي الاحوال إلا على ما أشرنا إليه من الاحتمال ولقد كثرت طرق
المتكلمين ههنا في طرفي النفي والإثبات لكن آثرنا الإعراض عنها شحا على
الزمان من التضييع فيما لا يتحقق به كبير غرض
والله الموفق للصواب
القاعدة الثانية
في اثبات الصفات النفسيةمذهب أهل الحق أن الواجب بذاته مريد بإرادة عالم بعلم قادر بقدرة حي بحياة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام وهذه كلها معان وجودية أزلية زائدة على الذات
وذهبت الفلاسفة والشيعة إلى نفيها ثم اختلفت آراء الشيعة فمنهم من لم يطلق عليه شيئا ما الأسماء الحسنى ومنهم من لم يجوز خلوه عنها وأما المعتزلة فموافقون للنفاة وإن كان لهم تفصيل مذهب في الصفات كما سيأتي
ونحن الآن نبتدئ بمعتمد أهل التعطيل وننبه على وجه إبطاله ثم نذكر بعد ذلك مستند أهل الحق فنقول
قال النفاة لو قدر له صفات فهى إما ذاتية او خارجية فإن كانت ذاتية فذات واجب الوجود متقومة بمبادئ زائدة عليها ولا يكون إذ ذاك والوجود بنفسه ثم إن تلك المبادئ إما أن تكون كلها واجبة أو ممكنة أو البعض واجب والبعض ممكن فإن كانت كلها واجبة أفضى إلى الإشراك في واجب الوجود وهو ممتنع فإنا لو قدرنا
وجود واجبين فإما أن يشتركا من كل وجه او يختلفا من كل وجه
أو يشتركا من وجه ويختلفا في آخر فإن اشتركا من كل وجه فلا تعدد في واجب
الوجود إذ التعدد والتغاير مع قطع النظر عن التميز محال وإن اختلفا من كل
وجه فلم يشتركا في وجوب الوجود وان اشتركا من وجه دون وجه فما به الاشتراك
غير ما به الافتراق لا محالة وعند ذلك فما به الاشتراك إن لم يكن وجوب
الوجود فليسا بواجبين بل أحدهما دون الآخر وإن كان هو وجوب الوجود فإما أن
يتم في كل واحد منهما بدون ما به الافتراق او لا يتم لا سبيل إلى القول
بالتمام إذ القول بتعدد ما اتحدت حقيقته من غير موجب للتغاير والتعدد
ممتنع جدا وإن لم تتم حقيقة وجوب الوجود في كل منهما إلا بما به الافتراق
فليس ولا واحد منهما واجبا بذاته إذ لا معنى لواجب الوجود بذاته إلا ما لا
يفتقر في وجوده إلى غيره وهذه المحالات كلها إنما لزمت من فرض الاشتراك في
وجوب الوجود والجمع بين واجبين لا محالة وكذا الكلام فيما إذا كان بعضها
واجبا وأما إن كانت ممكنة فهى لا محالة مفتقرة إلى مرجح خارج ولا يكون ما
جعل منها واجبا لذاته واجب الوجود من جميع جهاته وليس له فيما يتنظر فإذا
كان ممكنا من جهة فهو من تلك الجهة مفتقر إلى مرجح ويخرج عن كونه واجبا
بذاته مطلقا
وأما إن كانت الصفات خارجية غير ذاتية فإما أن تكون
قائمة بذاته أو غير قائمة بذاته فإن لم تكن قائمة بذاته فليست صفات وإن
سميت بذلك فحاصل النزاع يرجع إلى محض الإطلاقات وتلك لا مشاحة فيها وإن
كانت قائمة بذاته فهى إما واجبة أو ممكنة فإن كانت واجبة أدى إلى اجتماع
واجبين وهو محال كما سبق ثم القول بوجوبها مع افتقارها إلى ما تقوم به
محال وان كانت ممكنة فواجب الوجود لا يكون وجوبه مطلقا بل من جهة ما وهو
ممتنع كما مضى فإذا لابد أن يكون واجب الوجود واحدا من كل جهة من غير تعدد
لا بأجزاء كمية و لا بأجزاء حدية ولا يجوز عليه
ما وجب فيه
التعدد والتكثر وان كل ما وصف به واجب الوجود فليس حاصله يرجع إلا إلى سلب
ما كقولنا إنه واجب أي لا يفتقر إلى غيره في وجوده أو إلى إضافة ما
وكقولنا إنه أول أي إنه مبدأ كل موجود وعلى هذا النحو
ولربما قالت
النفاة من المعتزلة إنه لو كان له صفات وجودية زائدة على وجوده لم يخل إما
أن تكون هي هو أو هي غيره فإن كانت هي هو فلا صفة له وان كانت غيره فهي
إما قديمة أو حادثة فإن كانت حادثة فهو ممتنع إذ البارى تعالى ليس محلا
للحوادث كما يأتي وإن كانت قديمة فالقدم أخص وصف الإلهية وذلك يفضى إلى
القول بتعدد الآلهة وهو ممتنع كما يأتي أيضا وأيضا فلو قامت بذاته صفات
وجودية لكانت مفتقرة إليها في وجودها وذلك سيؤدي إلى أثبات خصائص الأعراض
للصفات وهو محال
والجواب أما القول بأنه لو كانت له صفات ذاتية لكان
متقوما بها وخرج عن أن يكون واجب الوجود لذاته فالخبط فيه إنما نشأ من
الجهل بمدلول لفظ الواجب بذاته فإنه إن أريد به ما ليس له صفات ذاتية ولا
خارجية فهو نفس المصادرة على المطلوب وإن أريد به ما ليس له علة خارجية عن
ذاته ولا افتقار إلى غير ذاته وسواء كان ذلك صفة أم لا فهو الصواب فإن
الدليل لم يدل إلا على ما يجب انتهاء جميع الحادثات إليه وانقطاع تسلسل
العلل والمعلولات عليه وهو غير مفتقر إلى أمر خارج عنه لكن مثل هذا الواجب
لا ينافى اتصافه بالصفات الذاتية إن لم تكن مفتقرة إلى أمور خارجية ونحن
وإن قلنا إنه
ذو صفات ذاتية فهي غير مفتقرة إلى أمر خارج بل كل
واحد منها واجب بذاته متقوم بنفسه وما ذكروه من امتناع وجود واجبين فإنما
يلزم أن لو كان ما به الاشتراك بينهما معنى وجوديا وأمرا إثباتيا وليس
كذلك بل ما وقع به الاختلاف ليس عوده إلا إلى نفى الماهيات والذوات بناء
على أصلنا في أن الوجود نفس الموجود وأن إطلاق اسم الوجود والذات على
الماهيات المتعدده ليس إلا بطريق الاشتراك في اللفظ لا غير وما وقع به
الاشتراك فليس إلا وجوب الوجود وحاصله يرجع إلى أمر سلبى وهو عدم الافتقار
في الوجود إلى علة خارجية وليس في إضافة هذا السلب إلى الذات المعبر عنها
بكونها واجبة الوجود ما يوجب جعل الواجب مفتقرا إلى غيره ولو وجب ذلك للزم
مثله في حق البارى تعالى وهو محال
ثم ولو قدرنا أن الوجود الذي يضاف
إليه الوجوب زائد على ما هية كل واحد منهما فإنما يلزم منه المحال أيضا أن
لو كان وجوب الوجود في كل واحد منهما لنفس الوجود الزائد عليه ولو قيل لهم
ما المانع من أن يكون واجبان كل واحد منهما له ماهية ووجود مستند في وجوبه
إلى تلك الماهية لا إلى معنى خارج ويكون معنى كونه واجبا لذاته أن وجوده
الزائد على ماهيته مستند إلى الماهية لا إلى نفسه لم يجدوا إلى دفعه سبيلا
بل ربما عولوا في إبطال ذلك على نفى الصفات وانتقاؤها لا يتم إلا بامتناع
اجتماع واجبين وذلك دور ممتنع
ولربما قالوا إذا جوزتم أن يكون
الوجود في واجب الوجود زائدا على ذاته وماهيته فهو لا محالة في وجوبه
مفتقر إلى الذات القائم بها وكل ما افتقر إلى غير نفسه في وجوبه فهو بذاته
ممكن وأذا كان ممكنا كان وجود واجب الوجود ممكنا وهو ما لا يتم إلا بمرجح
خارجى إذ الذات يستحيل أن تكون هي المرجحة والا لما كانت قابلة له إلا
باعتبار جهة أخرى غير جهة كونها فاعلة أذ تاثير العلة القابلة غير تأثير
العلة الفاعلية واختلاف
التأثيرات يستدعى اختلاف المؤثر إما في
نفسه أو باعتبار جهات واختلاف تأثير ذات واجب الوجود في وجوده بالفاعلية
والقابلية يستدعى اختلافه في ذاته أو في جهاته لكنه ليس مختلفا في ذاته
فلم يبق الاختلاف إلا باعتبار جهاته والكلام في تلك الجهات كالكلام في نفس
الوجود وذلك يفضى إلى ما لا يتناهى وهو محال
قلنا ما ذكرتموه إنما
يتم أن لو سلم أن طبيعة الممكن ما يفتقر إلى مرجح فاعل ولا مانع من أن
يقال إن الممكن ما لا يتم وجوده ولا عدمه إلا بأمر خارج عن ذاته وهو متوقف
في كلا طرفيه عليه وذلك قد يكون فاعليا وقد يكون قابليا وهو اعم من الفاعل
فعلى هذا إن قيل بأن الوجود ممكن باعتبار انه يفتقر إلى القابل فقد وفى
بجهة الإمكان ولا يلزم أن يفتقر إلى فاعل بل يجوز أن يكون وجوده لنفسه
وذاته وأن توقف على القابل والقول بأن وجوده لذاته مع توقفه على القابل
مما لا يتقاصر عنه قولكم أن العقل الفعال مؤثر في ايجاد الصور الجوهرية
والانفس الناطقه الانسانية بذاته وان كان تاثيره متوقفا على القوابل لما
تقتضيه ذاته
ثم إنه ما المانع من أن يكون تأثير ذات واجب الوجود
بالفاعيله والقابلية لا يتوقف على صفات وجودية حقيقية يلزم عنها التكثر
والتسلسل بل على صفات إضافية أو سلبية تكون تابعة لذات واجب الوجود من غير
أن يكون محلا لها أو فاعلا وهذا كما قلتم في صدور الكثرة عن المعلول الأول
لذات واجب الوجود فأنكم قلتم إن الصادر عنه نفس وعقل وجرم وذلك باعتبارات
متعددة لضرورة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد فأن كانت هذه الاعتبارات
صفات وجودية وأمور حقيقية فقد ناقضتم مذهبكم في قولكم الواحد لا يصدر عنه
الا واحد وإن كانت صفات إضافية أو سلبية لا توجب الكثرة والتعدد في الذات
وهي كما قلتم مثل كونه ممكنا ومثل كونه يعلم ذاته
ومبدأه فلم لا
يجوز أن يكون مما يجب فيه اختلاف التأثير أيضا باعتبار صفات أضافية أو
سلبية ولو قيل لهم ما الفرق بين الصورتين الميز بين الحالين لم يجدوا إلى
الخلاص عن ذلك سبيلا
وعلى ما ذكرناه من التحقيق ههنا يندفع ما ذكروه أيضا وإن نزل الكلام في
الصفات على جهة الإمكان دون الوجوب
وما قيل من أن القدم أخص وصف الألهية فإن أريد به أنه خاص بالله تعالى على
وجه لا يشاركه غيره من الموجودات فيه فلا مرية فيه وإن اريد به انه غير
متصور أن يعم شيئين ولو كانا داخلين في مدلول اسم الإلهية فكفى به في
الإبطال كونه مصادرة على المطلوب وهو لا محالة أشد مناقضة لمذهب الخصم إن
كان ممن يعترف بكون المعدوم شيئا وأنه ذات ثابتة في القدم في حالة العدم
على ما لا يخفى
وليس لما يتخيله بعض الأصحاب في الجواب ههنا سداد
وهو قوله لو كان القدم اخص وصف الالهية فمفهومه لا محالة غير مفهوم كونه
موجودا فالوجود إما أن يكون وصفا أعم أو أخص فان كان أعم فقد تألفت ذات
البارى من وصفين أعم وأخص ولو كان أخص فيلزم أن يكون كل موجود إلها وينقلب
الإلزام فإن الخصم قد لا يسلم الاشتراك في معنى الوجود وان وقع الاشتراك
في اسم الوجود وعند ذلك لا يلزم أن يكون كل ما سمى موجودا إلها وليس يلزم
من تعدد مفهوم اسمى الوجود والقدم تكثر في مدلول اسم البارى تعإلى إلا أن
يقدر نعتا وجوديا ووصفنا حقيقيا وليس كذلك بل حالصه
إنما يرجع إلى سلب الأولية لا غير وهذا يخلاف الصفات الوجودية
التي سلب عنها الأولية
وأما القول بأن قيام الصفات بالذات يفضى إلى ثبوت خصائص الأعراض لها فإنما
يستقيم أن لو كان ما قامت به تفتقر إليه في وجودها وتتقوم به كافتقار
السواد والبياض وسائر الأوضاع إلى موضوعاتها وليس كذلك بل القيام بالشئ
أعم من الافتقار إليه فإن الشئ قد يكون قائما بالشئ وهو مفتقر إليه في
وجوده افتقار تقويم كأفتقار الأعراض الى موضوعاتها وقد يكون قئم به وهو
غير مفتقر اليه افتقار تقويم وذلك كما يقوله الفيلسوف في الصور الجوهرية
بالنسبة إلى المواد وهي ليست بأعراض ولا لها خصائص الأعراض والمقصود من
هذا ليس إلا ان القيام بالشئ أعم من الافتقار إليه دفعا لما ذكروه من
الإشكال ومن لم يتحاش عن جعل هذا القدر خاصة للعرض فلا مشاحة معه في
الاصطلاحات وانما الشأن في نفيه لذلك عن الصفات ولا سبيل إليه بعد أن قلنا
إن الصفات زائدة على الذات وإلا فإن قلنا إنها عائدة إلى معنى واحد سيأتي
تحقيقه وإن الاختلاف إنما هو بسبب المتعلقات فقد اندفعت هذه الإشكالات
وطاحت هذه الخيالات هذا ما اعتمد عليه النفاة
وأما أهل الإثبات فقد
سلك عامتهم في الإثبات مسلكا ضعيفا وهو أنهم تعرضوا لإثبات أحكام الصفات
أولا ثم توصلوا منها إلى إثبات العلم بالصفات ثانيا فقالوا
العالم لا محالة على غاية من الحكمة والاتقان وهو مع ذلك جائز
وجوده وجائز
عدمه فما خصصه بالوجود يجب أن يكون مريدا له قادر عليه عالما به كما وقع
به الاستقراء في الشاهد فإن من لم يكن قادرا لم يصح منه صدور شئ عنه ومن
لم يكن عالما وإن كان قادرا لم يكن ما صدر عنه على نظام الحكمة والاتقان
ومن لم يكن مريدا لم يكن تخصيص بعض الجائزات عنه باحوال وأوقات دون البعض
بأولى من العكس إذ نسبتها إليه نسبة واحده قالوا
وإذا ثبت كونه
قادرا مريدا عالما وجب أن يكون حيا إذ الحياة شرط هذه الصفات على ما عرف
في الشاهد أيضا وما كان له في وجوده أو في عدمه شرط لا يختلف شاهدا ولا
غائبا ويلزم من كونه حيا أن يكون سميعا بصيرا متكلما فإن من لم تثبت له
هذه الصفات من الأشياء فإنه لا محالة متصف بأضدادها كالعمى والطرش والخرس
على ما عرف في الشاهد أيضا والبارى تعالى يتقدس عن أن يتصف بما يوجب في
ذاته نقصا
قالوا فإذا ثبتت هذه الأحكام فهي لا محالة في الشاهد
معللة بالصفات فالعلم علة كون العالم عالما والقدرة علة كون القادر قادرا
إلى غير ذلك من الصفات والعلة لا تختلف شاهدا ولا غائبا أيضا
واعلم أن هذا المسلك ضعيف جدا فإن حاصله يرجع إلى الاستقراء في الشاهد
والحكم على الغائب بما حكم به على الشاهد وذلك فاسد
وقبل النظر في تحقيقه يجب أن نقدم قاعدة في تحقيق معنى الاستقراء وبيان
الصادق منه والكاذب أما الاستقراء فهو عبارة عن البحث والنظر في جزئيات
كلى ما عن مطلوب ما وهو لا محالة ينقسم إلى ما يكون الاستقراء فيه تاما أي
قد أتى فيه على جميع الجزئيات وذلك مثل معرفتنا بالاستقراء أن كل حادث فهو
إما جماد أو نبات
أو حيوان فحاصل هذا الاستقراء صادق يقينى وإلى
ما يكون الاستقراء فيه ناقصا أي قد أتى فيه على بعض الجزئيات دون البعض
وحاصل هذا الاستقراء كاذب غير يقينى إذ من الجائز أن يكون حكم ما استقرى
على خلاف ما لم يستقر وذلك كحكمنا أن كل حيوان يتحرك فكه الاسفل عند الاكل
بناء على ما استقريناه في أكثر الحيوانات وقد يقع الامر بخلافه مما لم
يستقر وذلك كما في التمساح فإنه إذا اكل تحرك فكه الأعلى فعلى هذا إن لم
يكن الاستقراء في الشاهد تاما فهو كاذب
وإن قدر كونه تاما فإما أن
يكون الغائب والشاهد مشتركين في الحقيقة أو مختلفين فإن قدر الاختلاف فلا
يخفى أن ما حكم به على احد المختلفين غير لازم أن يحكم به على الآخر لجواز
أن يكون من خصائص ما حكم به عليه دون الآخر وذلك كما إذا حكمنا على
الإنسان بأنه ضاحك مثلا أخذا من استقراء جزئيات نوع الانسان فإنه لا يلزم
مثله في الفرس المخالف له في حقيقته
وإن قدر الاشتراك في الحقيقة
فهو محال وإلا للزم الاشتراك بينهما فيما ثبت لذات كل واحد منهما وإذ ذاك
فيجب أن يكون البارى والعالم واجبين أو ممكنين أو كل واحد منهما واجبا
وممكنا وهو ممتنع
ثم لو قدر أن ذلك غير محال فالاستقراء إما أن
يتناول الغائب أو ليس فإن تناوله فهو محل النزاع ولا حاجة إلى استقراء
غيره وان لم يتناوله بل وقع لغيره من الجزئيات فهو لا محالة استقراء ناقص
وليس بصادق كما بيناه وهذا لا محيص عنه ثم إن صح فيلزم أن يكون مشارا إليه
والى جهته وأن يكون إما جوهرا وإما عرضا كما في الشاهد وان لم يصح في هذه
الأمور لم يصح فيما سواها أيضا
ثم إن من قاس الغائب على الشاهد
ههنا فهو يعترف بأنه ليس في الشاهد فاعل موجد على الحقيقة بل الموجود في
حقه ليس إلا الاكتساب بخلاف ما في الغائب فإذا ما وجد في الشاهد لم يوجد
في الغائب وما وجد في الغائب لم يوجد في الشاهد فأنى يصح القياس
وأما القول بأنه إذا ثبت هذه الأحكام فهى معلله بالصفات كما في الشاهد فقد
قيل في إبطاله إن هذه الاحكام واجبة للبارى وكل ما وجب فإنه لا يفتقر إلى
ما يعلل به وهذا كما في الشاهد فإن التحيز للجوهر وقبوله للعرض لما كان
واجبا لم يفتقر إلى علة وإنما المفتقر الى العلة ما كان في نفسه جائزا غير
واجب وذلك مثل كون العالم عالما في الشاهد ومثل وجود الحادث ونحوه
وهذا غير صحيح فإنه إن أريد بكونها واجبة للبارى تعالى أنها لا تفتقر إلى
علة فهو عين المصادرة على المطلوب وإن اريد به انه لا بد منها لواجب
الوجود فذلك مما لا ينافى التعليل بالصفة والقول بأن التحيز للجوهر وقبوله
للعرض لما كان واجبا لم يفتقر إلى علة فهو مبنى على فاسد اصول المعتزلة في
قولهم إن هذه توابع الحدوث وتوابع الحدوث مما لا يدخل تحت القدرة ولا ينسب
إلى فعل فاعل وليس الرأي الصحيح عند أهل الحق هكذا بل كل ما يتخيل في
الأذهان ويخطر في الاوهام مما له وجود أصليا كان أو تابعا فهو مقدور له
تعالى ومخلوق له ومنتسب في وجوده إليه وليس شئ مما يفرض في الشاهد واجبا
بنفسه اللهم إلا أن يعنى بكونه واجبا أنه لازم لما هو ثابت له على وجه لا
تقع المفارقة له أصلا لكن الواجب بهذا الاعتبار غير ممتنع أن يكون معللا
كما سبق
فإن قيل هذه الامور اللازمة وان كانت مفتقرة إلى فاعل مرجح
لكنها لا تفتقر إلى صفة قائمة بمحلها تكون علة لها كما في افتقار العالمية
في الشاهد إلى صفة العلم
وهو المقصود بلفظ العلة وإذا لم تفتقر إلى علة لكونها لازمة
كذلك فيما نحن فيه قلنا
تفسير عدم افتقارها إلى العلة بالمعنى المذكور وإن كان صحيحا فقولهم إنها
لا تفتقر إلى علة لكونها لازمة دعوى مجردة وتحكم بارد بل لا مانع من أن
تكون معللة وإن كانت لازمة وتكون علتها ملازمة أيضا والقول بأنه لا يعلل
إلا ما كان جائزا فإنما ينفع أن لو كانت هذه الأحكام غير جائزة ولا يمنع
القول بجوازها من حيث إنه لا يمكن القول بعدمها إلا وقد لزم عنه المحال
لأن المحال قد يلزم عند فرض عدم الشئ لنفسه فيكون واجبا لذاته وقد يكون
فرض المحال لازما عن أمر خارج وان كان الشئ في نفسه ممكنا وذلك كما في فرض
عدم المعلول مع وجود علته كالكسر مع الانكسار ونحوه فمهما لم يتبين أن
المحال اللازم عند فرض عدم هذه الاحكام لازم لنفسها لا يلزم أن تكون واجبة
لنفسها فقد اندفع الاشكال وبطل ما أوردوه من الخيال
وليس من صحيح الجواب ما ذكره بعض الأصحاب ههنا وهو أن قال
قولكم بأن الواجب لا يعلل والجائز هو المعلل منتقض في كلا طرفيه أما
انتقاض طرف الجواز فهو أن الوجود الحادث جائز وليس بمعلل وأما انتقاض طرف
الوجوب فهو أن كون العالم عالما في الشاهد بعد أن ثبت واجب وهو معلل فإن
قوله ان الوجود الحادث جائز وليس بمعلل إنما يلزم أن لو قيل إن كل جائز
معلل بالصفة اما إذا قيل ان التعليل بالصفة ليس إلا للجائز فلا يلزم من
كون التعليل لا يكون الا للجائز أن لا يكون الجائز إلا معللا بالصفة إذ هو
كلى موجب ولا ينعكس مثل نفسه ألبتة
وأما القول بأن العالم بعد أن
ثبت كونه عالما في الشاهد واجب وهو معلل فالواجب لا محالة ينقسم إلى ما
وجوبه بنفسه و إلى ما وجوبه مشروط بغيره فإن أراد به أنه
واجب
بالمعنى الاول فقد ناقض حيث جعله معللا إذ الواجب بنفسه ما لا يفتقر إلى
غيره وإن اراد به الاعتبار الثاني فلم يخرج عن كونه جائزا فإن كل ما وجوبه
بغيره فهو جائز بنفسه على ما عرف فيما مضى وإذا كان جائزا فتعليله ليس
بممتنع وما يمتنع تعليله ليس إلا ما كان واجبا بنفسه أو ممتنعا وهذا وإن
كان واجبا فليس وجوبه بنفسه فلا يتجه به النقض
فإذا الصحيح أن يقال
في الإبطال ههنا ما قيل في ابطال الاحكام اولا كيف والخصم له أ ان يسلم
بثبوت هذه الاحكام للبارى تعإلى على وجه تكون النسبة بينها وبين أحكام
ذواتنا على نحو النسبة الواقعة بين ذاته وذواتنا وإذ ذاك فلا يلزم من
تعليل احد المختلفين ان يكون الآخر معللا وإن وقع الاشتراك بينهما في
الإطلاقات والأسماء
ولا يلزم عليه أن يقال ما تذكره في العلة مع
المعلول هو بعينه لازم لك في الشرط مع المشروط حيث إنك جعلت البارى حيا
لضرورة كونه شرطا لكونه عالما وقادرا مريدا كما في الشاهد فما هو اعتذارك
في الشرط هو اعتذارنا في العلة فإن للخصم إلا يسلم أن طريق إثبات كونه حيا
إثبات الاشتراط بل غيره من الطرق كيف والبينة المخصوصة عنده شرط في الشاهد
ومع ذلك لا يلتزم الاطراد في الغائب فكيف يلتزم الاطراد في غيره وما قيل
من أن حد العالم في الشاهد من قام به العلم وكذا القادر من قامت به القدره
والحد لا يختلف شاهدا وغائبا فحالصه يرجع إلى محض الدعوى وقد لا يسلم عن
منع أو معارضة وإذ ذاك فلا سبيل إلى دفعه إلا بأمور ظنية وقضايا تخمينية
لا حاصل لها
ثم إن من رام إثبات الصفات النفسية بطريق التوصل إليها
من أحكامها فهي لا محالة عنده أعرف من الصفات وإلا لما أمكن التوصل بها
إلى معرفها وإذا كانت الصفات
أخفى فكيف يوجد في حد الشئ أو رسمه
ما هو أخفى منه وشرط المعرف أن يكون أميز مما عرف به وإلا فإن كان اخفى
منه أو مثله في الخفاء فلا معنى للتعريف به ولما تخيل بعض الاصحاب عوص هذه
الطريقة لم يستند في إثبات احكام الصفات عند ظهور الإتقان في الكائنات
وكذا في إثبات الصفات عند ثبوت أحكامها إلى غير الضرورة والبديهة ولا يخفى
ما فيه من التحكم وسمج الدعوى ومع ذلك فقد لا يسلم من المعارضة بنقيضه وهو
مما يضعف التمسك به جدا
وقولهم إنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات
لكان متصفا بما قابلها وهو يتعالى ويتقدس عن أن يتصف بما يوجب في ذاته
نقصا فالكشف عن زيف هذا الكلام إنما يتحقق ببيان حقيقة المتقابلين وبيان
إقسامها أما المتقابلان فهما ما لا يجتمعان في شئ واحد من جهة واحدة وهذا
إما أن يكون في اللفظ أو في المعنى فإن كان في المعنى فإما أن يكون بين
وجود وعدم أو بين وجودين إذ الأعدام المحضة لا تقابل بينها فإن كان القسم
الأول فهو تقابل السلب والإيجاب وذلك كقولنا الإنسان فرس الإنسان ليس بفرس
وهو مما يستحيل اجتماع طرفيه في الصدق أو الكذب
وإن كان من القسم
الثانى فإما أن لا يعقل كل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر او ليس فإن كان
الأول فيسمى تقابل المتضايفين وذلك كما في الأبوة والبنوة ونحوهما ومن
خواص هذا التقابل ارتباط كل واحد من الطرفين بالآخر في الفهم وإن كان
الثانى فيسمى تقابل الضدين وذلك كالتقابل الواقع بين السواد والبياض ونحوه
ومن خواص هذا التقابل جواز انتقال طرفيه بالحركة إلى واسطة تكون بينهما
وأما إن كان من القسم الثالث فيسمى تقابل العدم والملكة
والمراد
بالملكة ههنا كل قوة على شئ ما مستحقة لما قامت به إما لذاته أو لذاتى له
وذلك كما في قوة السمع والبصر ونحوه للحيوان والمراد بالعدم هو رفع هذه
القوة على وجه لا تعود وسواء كان في وقت إمكان القوى عليه او قبله وذلك
كما في العمى والطرش ونحوه للحيوان فعلى هذا إن اريد بالتقابل ههنا تقابل
السلب والإيجاب في اللفظ حتى إذا لم يقل إن البارى ذو سمع وبصر لزم أن
يقال إنه ليس بذى سمع ولا بصر فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل بعينه من غير
دليل وإن أريد به ما هو من قبيل المتضايفين فهو غير متحقق ههنا ومع كونه
غير متحقق فلا يلزم من نفى أحد المتضايفين وجود الآخر ألبته بل ربما يصح
انتفاؤهما ولهذا يقال زيد ليس بأب لعمرو ولا بابن له ايضا وإن أريد به ما
هو من قبيل تقابل الضدين فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود مما هو قابل
لتوارد الإضداد عليه وذلك مما لا يسلمه الخصم وليس عليه دليل كيف وإنه لا
يلزم من نفى احد الضدين وجود الآخر بل من الجائز أن يجتمعا في العدم
والسلب ولهذا يصح أن يقال إن البارى تعالى ليس بأسود ولا أبيض ولو لزم من
نفى احد الضدين وجود الآخر لما صدق قولنا بالنفى فيهما وأما إن أريد به ما
هو من قبيل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفى الملكة تحقق العدم
ولا من نفى العدم تحقق الملكة ولهذا يصح أن يقال الحجر ليس باعمى ولا بصير
نعم إنما يلزم العدم المذكور من ارتفاع القوة الممكنة للشئ المتسحقة له
لذاته او لذاتي له كما بينا والقول بارتفاع مثل هذه القوة في حق البارى
يجر إلى دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب وهو غير معقول
فإذا
السبيل الذليل في إثبات الصفات إنما يتضح بالتفصيل وهو أن نرسم في كل واحد
منها طرفا ونذكر ما يتعلق به من البيان ويختص به من البرهان ونكشف عما
يشتمل عليه من الاقاويل الصحيحة والفاسدة ولتكن البداية بتقديم النظر في
صفة الإرادة أولا
الطرف الاول
في اثبات صفة الارادةمذهب أهل الحق أن البارى تعالى مريد على الحقيقة وليس معنى كونه مريدا إلا قيام الإرادة بذاته وذهب الفلاسفة والمعتزلة والشيعة إلى كونه غير مريد على الحقيقة وإذا قيل إنه مريد فمعناه عند الفلاسفة لا يرجع إلى الا سلب او إضافة ووافقهم على ذلك النجار من المعتزلة حيث أنه فسر كونه مريدا بسلب الكراهية والعلية عنه وأما النظام والكعبى فإنهما قالا إن وصف بالارادة شرعا فليس معناه إن أضيف ذلك إلى افعاله إلا أنه خالقها وإن أضيف إلى افعال العباد فالمراد به أنه امر بها وزاد الجاحظ على هؤلاء بإنكار وجود الإرادة شاهدا وقال مهما كان الإنسان غير غافل ولا ساه عما يفعله بل كان عالما به فهو معنى كونه مريدا وذهب البصريون من المعتزلة إلى أنه مريد بإرادة قائمة لا في محل وذهب الكرامية إلى أنه مريد بإرادة حادثة في ذاته تعالى الله عن قول الزائغين
والذي يقطع دابر أهل التعطيل أن يقال لو لم يصدق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذى ارادة ولو صدق ذلك أنتج قلبه معدولا لضرورة وجود الموضوع وقلبه إلى
المعدول يجعل حرف السلب متأخرا
عن الرابطة الواقعة بين المفردين وصورة ذلك أن يقال البارى هو ليس بذي
إرادة ولو صح ذلك فلنا أن نقول وكل ما ليس بذى إرادة فهو ناقص بالنسبة إلى
من له إرادة فإن من كانت له الصفة الإرادية فله أن يخصص الشئ وله أن لا
يخصصه شاهدا فالعقل السليم يقضى أن ذلك كمال له وليس بنقصان حتى إنه لو
قدر بالنظر إلى الوهم سلب ذلك الأمر عنه كان حاله أولا أكمل بالنسبة إلى
حاله ثانيا وعند ذلك فما سلب منه هذا الكمال قدر ذلك المسلوب عنه شاهدا أو
غائبا إما أن يكون بالنظر إلى ما سلب عنه ووجب للآخر أنقص مما ثبت له هذا
الكمال او أكمل أو لا أكمل ولا أنقص لا جائز أن يكون أكمل وإلا كان ما ثبت
له ذلك الامر من جهة ما ثبت له ناقصا وهو محال ولا جائز أن يكون لا أنقص
ولا أكمل وإلا لما كان وجود ذلك الأمر كمالا لما اتصف به بل وجوده وأن لا
وجوده بالنظر إليه سيان لضرورة مساواته ما لم يتصف به من جهة عدم اتصافه
به وذلك محال فلم يبق إلا أن يكون ما لم يتصف به أنقص مما هو متصف به وعند
ذلك فيكون هذا الاقتران مؤلفا من شرطية صغرى وحملية كبرى ناتجا نتيجة
شرطية مقدمها مقدم الشرطية وتاليها هو محمول الحملية وصورته أن يقال
لو لم يصدق كونه ذا كونه ذا إرادة للزم أن يكون أنقص ممن هو ذو إرادة وهذا
الإنتاج إنما يتم بقلب مقابل المطلوب معدولا وإلا فمع بقائه سالبا
فالمقدمة الكبرى تكون كاذبة لكونها موجبة والموجبة تستدعي وجود الموضوع
والموضوع في السالب إذا كان حدا أوسط غير متحقق الوجود وإذا عرف الإنتاج
ولا يخفى ما فيه من المحال فإنه كيف يتصور أن يكون المخلوق أكمل من الخالق
والخالق أنقص منه والبديهة تقضى برده وإبطاله فإذا قد لزم المحال عن هذا
القياس وذلك إما أن يكون لازما لصورته أو لمادته الصورة صحيحة لا مراء
فيها وان كان لزومه عن المادة فإما أن يكون لازما عن المقدمة الصغرى
أو الكبرى لا جائز أن يكون لازما عن الكبرى إذ هي صادقة مسلمة
والصادق لا
يلزم عنه محال فبقى أن يكون لازما عن المقدمة الصغرى التي هي لازم نقيض
المطلوب فتكون كاذبة ومهما كان نقيض المطلوب كاذبا كان المطلوب هو الصادق
لضرورة أن القضية لا تخلو عن صدقها أو صدق نقيضها ويلزم منه ثبوت الإرادة
وإن شئت أن تلبس هذا المعنى صورة شرطية قلت لو لم يتصف بالإرادة لكان أنقص
مما اتصف بها لما بيناه والتالى باطل فالمقدم باطل
فإن قيل هذا اللزوم متوقف على تحقيق الإرادة شاهدا وبم الرد على الجاحظ في
إنكارها قلنا كل عاقل يجد من نفسه العزم والإرادة والقصد والتفرقة الواقعة
بين الفعل الواقع على وفق الإرادة والواقع على خلافها وذلك كما في حركة
المرتعش والمختار كما يجد من نفسه أن له علما وقدرة ونحو ذلك ولا يمكن
إسناد ذلك إلى العلم فان التفرقة قد تحصل بين الشيئين وإن كان تعلق العلم
بهما على السواء وهذا مما لا ينكره عاقل إلا عنادا ثم ولو جاز إنكار ذلك
شاهدا لجاز إنكار العلم والقدرة إذ لا فرق بينهما وبين الإرادة فيما يجده
الإنسان في نفسه ويحسه في باطنه
فإن قيل فلو سلم ذلك وسلم بثبوت صفة
الأرادة شاهدا فما اعتمدتم عليه منتقض بالشم والذوق واللمس وغير ذلك من
كمالات الموجودات شاهدا كيف وأن ما تنسبونه له من الصفة إما أن يكون من
جنس ما في الشاهد أو ليس فإن كان الأول فهو محال وإلا للزم أن تكون مشاركة
للإرادة شاهدا في جهة العرضية والإمكان ويلزم أن يكون البارى محلا للأعراض
وهو متعذر وإن كان الثاني فهو غير معقول وما ليس بمعقول
كيف نسلم كونه كمالا للرب تعالى وأن عدمه نقصان وهل ذلك كله إلا
خبط في عشواء
قلنا أما النقض فمندفع إذ المحصلون لم يمنعوا من إثباتها له لكن بشرط
انتفاء الاسباب المقترنة بها في الشاهد الموجبة للحدث والتجسيم ونحو ذلك
مما لا يجوز على الله تعالى كما جوزوا عليه الإدراك والسمع والبصر لكن لم
يتجاسر على إطلاقها في حق البارى تعالى لعدم ورود السمع بها والحاصل أنه
مهما ثبت من الكمالات شاهدا فلا مانع من القول بإثباتها غائبا مع هذا
الإشتراط وأما من فرق بين كمال وكمال من أهل الحق فلعله لم ير ما نفاة مما
يتم إلا بأمور موجبة للحدث والافتقار كاتصالات ومماسات وتقابلات إلى غير
ذلك بخلاف ما أثبته أو أنه مما ليس بكمال في نفسه وذلك مثل ما يتخيل من
معنى اللذة والألم والشهوة ونحوه والأغوص إنما هو الأول وهو القول بأن كل
ما ثبت كونه كمالا في الشاهد ولم يجر القول بإثباته في حق الغائب إلى نقص
أو افتقار فالقول به واجب وإن لم يصح إطلاقه من جهة التلفظ عليه لعدم ورود
السمع به
وأما ما ذكروه من المجانسة فلنا أن نقول بها تارة وننفيها
أخرى فإن قلنا بالمجانسة فغاية ما يلزم منه الافتقار إلى المحل المقوم إذ
هو المعنى بكون الشئ عرضا وذلك مما لا نأباه إلا أن يقول المقوم للصفة
والمخصص بها امر خارج عن ذات واجب الوجود وليس كذلك كما حققناه هذا إن
قلنا بالمجانسة
وإن قلنا بنفيها فلا التفات إلى من قصر فهمه عن درك
ما أثبتناه وزعم أنه غير معقول فإنه وإن يكن من جنس صفات البشر فلا يلزم
أن لا يكون معقولا وأن لا يمكن
التعرض لإثباته ونفيه وإلا كان
وجود البارى تعالى غير معلوم ولتعذر القول بإثباته فصفة الإرادة لواجب
الوجود وإن لم تكن مجانسة لصفة الإرادة شاهدا فلا محالة أن نسبتها إلى ذات
واجب الوجود كنسبة الإرادة شاهدا إلى النفس الناطقة الإنسانية من التعلق
والمتعلقات وكل عاقل يقضى ببديهته إن الإراده شاهدا بالنسبة الى محلها
كمال له وان عدمها بالنسبة له نقصان و يوجب ان ما كانت نسبته إلى واجب
الوجود كنسبة الإرادة على محلها شاهدا أن يكون كمالا لذات واجب الوجود وان
عدمه يكون نقصانا فلو لم نقل بثبوت لذات واجب الوجود لوجب أن يكون واجب
الوجود ناقصا في رتبته بالنسبة إلى رتبة المخلوق من جهة أن كمال المخلوق
حاصل له وكمال الخالق غير حاصل له
فإن قيل لو سلمنا بثبوت صفة
الإرادة في حق البارى تعالى فما المانع من ان تكون أمرا سلبيا ومعنى عدميا
كما قاله الفلاسفة والنجار من المعتزلة
قلنا لأن السلب عدم محض وذلك
لا تأثير له في التمييز والتخصيص إذ ما ليس بشئ لا يكون مستوعبا لما هو شئ
ولأنه لا فرق إذ ذاك بين قولنا إنه لا مميز وبين قولنا إن المميز عدم ثم
كيف يصح تفسير الإرادة بعدم الإكراه وهو منتقض طردا وعكسا
أما الطرد
فهو أن كثيرا ما الأشياء قد تنتفى عنه الكراهية ولا موجب لكونه مريدا وذلك
كما في الجماد بل الإنسان في غالب أحواله كما في حالة النوم والغفلة فإنه
لا يوصف فيها بكونه كارها ولا مريدا
وأما العكس فهو أن الإنسان قد يوصف بالإرادة لما هو كاره له كما
في حالة شرب الدواء المسهل ونحوه
فإن قيل تفسيرها بالعدم وإن كان ممتنعا فما المانع من أن تكون لا موجودة
ولا معدومة كما يقوله مثبتو الأحوال
فقد أشرنا إلى وجه إفساده فيما مضى فلا حاجة إلى اعادته فإن قيل فلو سلم
أنها صفة وجودية فلم يجب أن تكون قائمة بذات الرب تعالى وما المانع من أن
تكون قائمة لا في ذاته كما هو مذهب البصريين من المعتزلة
قلنا لو لم
تكن قائمة بذاته لم يخل إما أن تكون قائمة في محل أو لا في محل فإن كانت
قائمة في محل فالمحل إما قديم أو حادث فإن كان حادثا فهو لا محالة مفتقر
في وجوده إلى مخصص والمخصص إما نفس ما قام به من الإرادة او أخرى غيرها لا
جائز أن تكون نفسها وإلا أفضى إلى الدور من جهة توقف كل واحد منهما على
صاحبه ولا جائز أن يقال بإرادة أخرى غيرها وإلا أفضى إلى التسلسل من جهة
أن الكلام في المخصص الثاني كالكلام في الأول ثم إنه ليس القول بنسبتها
إلى البارى بكونه مريدا لها بأولى من نسبتها الى محلها بل هو أولى
وكذا الكلام فيما إذا كان قديما أيضا وأما إن كانت قائمة لا في محل فقد
قال
بعض الأصحاب في رده يلزم أن تكون إرادة في الشاهد هكذا إذ ما ثبت
للحقيقة
في موضع لا يتخلف عنها أين وجدت وحقيقة الإرادة لا تختلف شاهدا وغائبا فإن
استغنت عن المحل غائبا وجب أن تكون مستغنية عنه شاهدا وهو محال وهذا إنما
يستقيم أن لو سلم اتحاد حقيقة الإرادة شاهدا وغائبا ولعل الخصم قد يجعل
نسبة الإرادة غائبا إلى الأرادة شاهدا على نحو النسبة الواقعة بين الذات
الواجبة غائبا والذوات الموجودة شاهدا وإذ ذاك فالإلزام يكون به منقطعا لا
بما قيل من إنكار وجود الإرادة شاهدا لما بيناه فالصحيح أن يقال لو كانت
قائمة لا في محل لم يخل إما أن تكون حادثة أو قديمة فإن كانت حادثة فأما
أن تكون باعتبار ذاتها واجبة أو ممكنة لا جائز أن تكون واجبة وإلا لما
كانت معدومة وإن كانت ممكنة فإما أن تفتقر إلى مخصص آخر أو لا تفتقر لا
جائز أن يقال بالاول وإلا أفضى إلى التسلسل وهو محال ولا جائز أن يقال
بالثانى وإلا لما وجدت إذ لا مميز لها على ما يخصص بها من حيث هي ممكنة
وما نخصص بها إنما كان مفتقرا إليها من حيث هو ممكن لا من حيث إنه ذات
مخصوصة وحقيقة معينة
فإن قيل المخصص لا يستدعي مخصصا وإن كان حادثا
كما في الشاهد فإن من وجد له إرادة لا تستدعي تلك الإرادة أخرى وإلا أفضى
إلى التسلسل وأن لا يتم لأحد إراداة الا مع وجود إرادات لا تتناهى وذلك
مما يحس من النفس بطلانه وربما مهدوا ذلك بأمثلة أخرى مثل التمنى والشهوة
ونحو ذلك
قلنا أما القول بأن المخصص لا يستدعى مخصصا فهو دعوى مجردة
من غير دليل كيف وقد بينا وجه الاحتياج والافتقار مما لا سبيل إلى أنكاره
وما قيل من أن الإرادة في الشاهد لا تفتقر إلى إرادة فغلط بل لا بد لها من
مخصص من جهة كونها ممكنة وحادثة
وإن لم يكن المخصص من جهة من له الإرادة شاهدا وعلى هذا يخرج كل
ما يهولونه من الأمثال غير هذا المثال
وأيضا فإنها لو كانت حادثة لا في محل لم تكن نسبتها إلى البارى تعالى
بكونه مريدا بأولى من نسبتها الى غيره من الحوادث وليس يجب القول بتغير
نسبتها إليه لما بيناه من الاشتراك في نفي المحلية عنهما فإنه مع ما فيه
من انتفاء جهة اللزوم ليس هو بأولى من نسبتها إلى غيره من الحوادث لما
بينهما من الاشتراك في الحدوث بل وهو الاولى من حيث إن ما يتحقق بين
الحوادث من الاشتراك والنسب أكبر منها بين القديم والحادث على ما لا يخفى
ثم ولو وجب نسبتها إليه لما اشتركا فيه من نفى المحلية لوجب نسبتها إلى
سائر الجواهر والأجسام إذ هي مشاركة لها في هذا المعنى كيف وإنه لو جاز أن
يكون مريدا بإرادة قائمة لا في ذاته لجاز أن يكون عالما بعلم قائم لا في
ذاته وقادرا بقدرة قائمة لا في ذاته إلى غير ذلك من الصفات ولم يقولوا به
ولجاز أيضا ان يكون الواحد منا عالما وقادرا بعلم قائم لا في ذاته وقدرة
قائمة لا في ذاته ولم يقولوا به أيضا والتحكم بالفرق من غير دليل مما لا
سبيل إليه وبهذا تبين إبطال القول بالقسم الثاني أيضا كيف وإنه مما لا
قائل به فلم يبق إلا أن تكون قائمة بذات الرب تعالى
وإذا كانت قائمة
بذاته فإما ان تكون قديمة أو حادثة لا جائز أن تكون حادثة كما ذهب إليه
الكرامية إذ قد بينا وجه إبطاله ولا حاجة إلى إعادته وسنبين امتناع
قيام الحوادث بذات الرب تعالى فيما بعد إن شاء الله تعالى فتعين
أن يكون الرب تعالى مريدا بإرادة قديمة قائمة بذاته وهو ما أردناه
فإن قيل فلو كان المخصص قديما لانقلب ما ذكرتوه في امتناع إضافة التخصيص
إلى ذات واجب الوجود عليكم فيما تدعونه مخصصا فإنه إذا كان قديما فنسبة
الأحوال والأوقات والأضداد وكل ما يقدر بالإضافة إليه على وتيرة واحدة فما
خصصه بزمان الحدوث إن افتقر إلى مخصص آخر فالكلام في ذلك المخصص الثاني
كالكلام في الأول وذلك يفضى إلى التسلسل وهو ممتنع وإن لم يفتقر إلى مخصص
آخر فما هو جواب لكم في الإلزام ههنا أي في الإرادة هو جواب لنا في الذات
قلنا قد بينا أنه لابد من إرادة قديمة كان بها التخصيص وليس ما ذكرناه في
إبطال التخصيص بالذات مما ينقلب في الإرادة فإنه إذا قال القائل لم خصصت
الإرادة هذا الحادث بزمان حدوثه وليس هو بأولى مما قبله أو بعده كان
السؤال في نفسه خطأ من جهة أن الإرادة عبارة عما يتأتى به التخصيص للحادث
بزمان حدوثه لا ما يلازمه التخصيص فإذا قيل لم كانت الإرادة مخصصة فكأنه
قال لم كانت الإرادة إرادة وهو في نفسه محال وهذا كما لو قال لم كان
الواجب بذاته لا يفتقر إلى علة والممكن بذاته يفتقر إلى علة في كل واحد من
طرفيه فإنه يقبل من حيث إن سؤاله يتضمن القول بأنه لم كان الواجب واجبا
ولم كان الممكن ممكنا فإن الواجب هو عبارة عما لا يفتقر إلى غيره في وجوده
والممكن بعكسه وهو مما لا يخفى وجه فساده وهو لا محالة إن
ورد من
الفلسفى أظهر في الفساد من جهة اعترافه بإسناد جميع الحادثات والأمور
المتجددات كالحركات وغيرها إلى الإرادات النفسية الثابتة للأجرام الفلكية
ولا مندوحة عنه
فإن قيل لو سلم قيام المخصص بذات الرب تعإلى وكونه قديما لكنه مما يمتنع
تفسيره بإلإرادة لوجهين
الوجه الأول هو أنه لو كان مخصصا بالإرادة لما خصصه فلا بد من أن يكون
قاصدا لما خصصه وطالبا له بل يتعالى ويتقدس عن الأغراض وإنما هي عائدة إلى
المفعول
المرجح وذلك مما لا يوجب تحققه للغير ولا عدمه نقصا ما والذي يوضح هذا هو أن ما ظهر من حكمة بعثة الرسل والأنبياء وتبليغهم ليس إلا إصلاح الخلق وتقويم نظامهم وإن كنا نعلم أن عدم هذه الحكمة ووجودها بالنسبة إلى حال النبى سيان فيما يرجع إلى نفس كماله ونقصانه وهذا مما لا ينكره عاقل إلا عن عناد ثم إن هذا مما لا يصح إيراده ممن يعترف بكون البارى تعالى مريدا من المعتزلة وغيرهم وإن ورد من الفلاسفة الإلهيين
ومن تابعهم فهو لازم عليهم أيضا فإنهم قضوا بأن الترجيح في
الوجود وغيره
إنما يستند الى ذات واجب الوجود وإن ما وجب به لا يتأخر وجوده عن وجوده بل
هو ملازم له في الوجود كملازمة حركة الخاتم لحركة اليد كما سيأتي تفصيل
مذهبهم
وعند ذلك فنقول ملازمة ما وجد به ووجب عنه إما أن تكون
وعدمها سيان أو أن الملازمة أولى فإن كانت الملازمة وعدمها سيان فالقول
بوجوب اللزوم في الوجود متناقض وإن كانت الملازمة هي الأولى فلا محالة أن
ما هو الأولى في لزومه له أنه يستفيد بملازمته كمالا وبعدمه نقصانا فإذا
ما هو اعتذارهم في الذات هو اعتذارنا في الإرادة ولا محيص عنه
وما
يلزمهم أيضا في ذلك أن تكون الأنفس الفلكية المخصصة للحركات الدورية كما
عرف من مذهبهم متوقفة في حصول كمالها على معلولها لكونها مخصصة له
بالإرادة وفي ذلك توقف كمال الأشرف على المشروف ولا خلاص لهم منه
وأما ما ذكروه من الوجه الثاني في قولهم لو كانت صفة نفسية قديمة لما
تعلقت ببعض المتعلقات دون البعض كما في العلم فمع أنهم قد نقضوا ما أبرموه
وحلوا ما عقدوه بالقدرة فإنهم قالوا إنها صفة قديمة نفسية ولا تعلق لها
بأفعال العباد فهو صحيح
وسنبين فيما بعد إن شاء الله أنه لا خالق
الا الله ولا مبدع إلا هو وأن الإبداع والخلق لجميع الحادثات لا يكون إلا
عن إرادة واختيار لا عن طبع واضطرار كيف وإنه لو لم تتعلق إرادته بجميع
الكائنات لكان كمال واجب الوجود بالنسبة إلى ما لم تتعلق به إرادته من
الكائنات أنقص بالنسبة إلى حال من تعلقت به إرادته من المختارين وهو محال
وما ذكروه من المحالات وأوردوه من الإلزامات غير متجه
أما الأول وهو
قولهم يلزم أن يكون مريدا لإرادة زيد وعمرو عند اختلاف مراديهما فقد منع
بعض الأصحاب من تصور اجتماع مثل هاتين الإرادتين وقال إن ما علمه الله على
ما هو عليه وإنه سيكون اولا يكون فهو المراد ونقيضه تشبه غير مراد فعلى
هذا تصور الإرادتين عند تعلقهما بنقيضين ممتنع وهو مما فيه نظر فإن ما وجد
من كل واحد منهما مماثل لما وجد من صاحبه فيما يرجع إلى الميل والقصد
والاختلاف ليس إلا في التعلق وكون أحدهما واقعا على الوفق والآخر على
خلافه فإن كان ذلك هو الموجب تسمية البعض إرادة والبعض شهوة فحاصله يرجع
إلى الاصطلاح في الأسماء لا الاختلاف في المعنى وهو ما يوجد في كل واحد
منهما
فالذي يتجه وله ثبات على محك النظر أن يقال إنما يلزم هذا
المحال أن لو لزم من تعلق إرادته بإرادتهما تعلقها بمراديهما وليس كذلك بل
المدعى به متحكم بما لا دليل عليه فالرأي الحق أن يقال إن تعلقها
بالإرادتين إنما كان بالنظر إلى حدوثها وتخصصها بالوجود دون العدم وذلك
مما لا يوجب تضادا ولا تناقضا والجمع بين متعلقيهما و إن كان محالا
فإنما يلزم أن لو لزم تحققه في متعلقهما به أي من تعلق الإرادة
القديمة
بهما وليس كذلك بل متعلق كل واحد منهما إنما يتم بتعلق الإرادة القديمة به
وذلك غير لازم من تعلقها بإحداث الإرادة الحادثة المتعلقة به
وأما
المحال الثاني فقد أجاب عنه بعض الأصحاب بأن قال أفعال المكلفين وإن
انقسمت إلى خيرات وشرور لكن الإرادة إنما تتعلق بها من حيث وجودها وتحققها
وهي من هذا الوجه ليست بشرور بل خيرات محضة وإنما تلحقها الشرور باعتبار
الصفات التي هي منتسبة إلى فعل العبد وقدرته وهي ما قلتم انها توابع
الحدوث كما يأتى تحقيقه في مسألة خلق الأفعال وهى ما قلتم انها توابع
الحدوث كما يأتى تحقيقه في مسألة خلق الأفعال وهى من هذه الجهة ليست مرادة
لله تعالى على الاصلين فإن إرادة فعل العبد من حيث إنه فعله تمن وشهوة
وذلك في حق البارى محال فإذا ما هو مراد الله تعالى إنما هو التخصيص
والإحداث وذلك هو الخير وما هو الشر ومنه الشر فهو ما وقع مسندا إلى فعل
العبد من حيث هو فعله وذلك غير مراد الله تعالى
وسنبين إبطال هذا
المقال في مسألة خلق الأعمال وأن ما من حادث إلا وهو مضاف إلى البارى
تعالى بأنه محدثه ومريد له وأنه لا خالق الا الله تعالى ولا مبدع إلا هو
وأنه لا يجرى في ملكه إلا ما هو مراد له ومن حيث هو مراد له ليس بشر فإن
تعلق الإرادة به إنما هو من جهة تخصصه بالوجود دون العدم او العدم دون
الوجود و بالجملة من جهة تخصصه ببعض الاحوال دون البعض وذلك مما لا يوصف
بكونه شرا من حيث هو كذلك نعم إن وصف بعض الحادثات بكونه شرا فذلك ليس هو
لعينه ولا أن الشر وصف ذاتى له ولا هو في نفسه معنى وجودى بل معنى نسبى
وأمر إضافى كما يأتي تحقيقه في مسألة التحسين والتقبيح وذلك مما لا يمنع
من إضافته إلى الإرادة القديمة وإلا لما أضيف إليها ما في عالم
الكون والفساد من التحريق والتغريق والخسف والزلازل والهدم ونحو
ذلك من الآفات الفادحة والأمراض المؤلمة وغير ذلك مما لا يقولون به
ثم إن مستندهم فيما ذكروه ليس إلا الشاهد ولو صح أن يقال الغائب باعتبار
إرادته للشر شرير كما في الشاهد لصح أن يقال إذا أراد الطاعة مطيع
فإن قيل تسمية الواحد منا مطيعا إنما كان بالنسبة إلى ما أراده وقصده مما
هو مأمور به وملجأ اليه والبارى تعالى منزه عن ذلك
قلنا فما المانع من أن تكون تسمية الواحد منا أيضا شريرا أو سفيها بالنسبة
إلى ما قصده من جهة أنه منهى عنه وممنوع منه كيف وأن هذا هو الحق وأن
الصبى والمجنون لو أتيا بمثل ما يأتي به المطيع والشرير فإنه لا يقال لهما
مطيع ولا شرير ولم يكن ذلك إلا لعدم ورود التكليف نحوه هذا إن ورد من
المعتزلة
وأما الفلاسفة فلهم تفصيل مذهب في معنى الخير والشر وهو ما
لا تمس الحاجة إلى ذكره وإن من حقق ما قررناه أمكنه التفصى عن كل ما
يتخيلونه ههنا
وأما المحال الثالث
فإنما يلزم أن لو كان
المأمور والمنهى مرادا وليس كذلك بل المأمور الذي علم وقوعه والمنهى الذي
علم الانتهاء عنه هو المراد أما ما علم إنتفاؤه فليس بمراد الوجود وإن كان
مأمورا به وما علم وجوده فليس بمراد الانتفاء وإن كان منهيا عنه
وإلا كان فيه إبطال أخص وصف الإرادة وهو تاتي التمييز بها وهو ممتنع وأما
ما يطلق عليه اسم الإرادة مع عدم حصول التمييز به فليس في الحقيقة إرادة
بل شهوة وتمنيا فإذا الارادة اعم من الأمر من جهة أنها توجد ولا أمر
والأمر أعم منها من جهة أنه قد يكون ولا إرادة وليس ولا واحد منهما يلزم
الآخر لزوما معاكسا ولا غير معاكس وعند ذلك فلا يلزم من الأمر بالوجود
وإرادة العدم ما تخيلوه من التناقض وعلى هذا القول في النهى أيضا
ثم
كيف ينكر ذلك مع الاعتراف بتكليف أبى جهل بالإيمان من غير إرادة له وبما
ظهر من قصة إبراهيم في تكليفه بذبح ولده كما يأتي تحقيقه فيما بعد إن شاء
الله تعإلى فإذا ليس ثمرة الأمر امتثال ما أمر به بل من الجائز أن تكون له
ثمرة أخرى وعند ذلك فلا يكون عبثا ولا متناقضا كما في هذه الصور ولهذا قال
بعض الأصحاب إنه لو علم من أحد من الامة أنه لو كلف بخصله من خصال الخير
لم يأت بها ولو ضوعفت عليه لم يقصر عنها فإنه إذا امر بالضعف كان امرا
صحيحا وإن لم يكن ما أمر به مرادا وذلك على نحو امر النبى صلى الله عليه و
سلم ليلة المعراج بالصلوات هذا كله إن قيل برعاية الصلاح وإلا فلا حاجة
إلى هذا التكليف ولا غرض في هذا التعبد وما قيل من انه يفضى إلى التكليف
بما لا يطاق فذلك مما لا نأباه وسنبين وجه جوازه فيما بعد إن شاء الله
وما أشير إليه من الظواهر الدالة على نفى الإرادة والرضى للقبح والفساد
مما لا يسوغ التمسك بها في مسائل الأصول إذ هي مع ما يقابلها من ظواهر
أخرى ممكنة التأويل جائزة التخصيص والمقطوع لا يستفاد من المظنون كيف وإن
القول بموجبها متجه ههنا فإنا لا نعترف
بأن إرادته ورضاه مما
يتعلق بالمعاصى على اختلاف أصنافها إذ هي من حيث هي شرور ومعاص امور
إضافيه لا ذوات حقيقية كما سنبين والإرادة لا تتعلق بها إنما تتعلق بها من
حيث الحدوث والتجدد كما سبق ومن تمسك بهذه القاعدة استغنى عن التأويل
بطريق التفصيل كيف وأنا سنقرر قاعدة في معنى المحبة والرضى و الإرادة يمكن
أن نتوصل منها إلى تأويل كل ما يرد من هذا القبيل
اما المحبوب
والمرضى في حق الله تعالى فليس معناه إلا أنه ممدوح عليه في العاجل ومثاب
عليه في الآجل كما أن المسخوط المقابل له ليس معناه إلا نقيض ما ذكرناه
فعلى هذا معنى قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول وقوله لا يحب
الفساد وقوله ولا يرضى لعباده الكفر أنه غير ممدوح ولا مثاب عليه وهكذا
تأويل كل ما يرد من هذا القبيل
وأما الإرادة فإنها قد تتعلق
بالتكليف من الأمر والنهى وقد تتعلق بالمكلف به أى إيجاده وإعدامه فإذا
قيل إن الشئ مراد فقد يراد به إن التكليف به هو المراد لاعينه وذاته وقد
يراد به أنه في نفسه هو المراد أى إيجاده أو إعدامه فعلى هذا ما وصف بكونه
مرادا ولا وقوع له فليس المراد به إلا التكليف به فقط وما قيل إنه غير
مراد وهو واقع فليس المراد به إلا أنه لم يرد التكيلف به فقط
ومن
حقق هذه القاعدة أمكنه التقصى عن قوله وما الله يريد ظلما للعباد بأن يقال
المراد به إنما هو نفى الإرادة بالتكليف به لا من حيث حدوثه وكذا قوله
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر معناه الأمر باليسر ونفيه عن
العسر وعلى هذا يخرج قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإنه ليس
المراد به وقوع العبادة بل الأمر بها
وقول بعض الأصحاب في تقرير
الأمر بما ليس بمراد إن ما يتعلق به الأمر والنهى إنما هو أخص وصف فعل
المكلف وهو ما يصير به طائعا أو عاصيا وذلك الأخص هو ما يتعلق بكسبه ويدخل
تحت قدرته وبه يتحقق معنى التكليف وهو ما جعلته المعتزلة من توابع الحدوث
لا أن التكليف متعلق بأصل الفعل إذ هو فعل الله تعالى وذلك لا يجوز
التكليف به إذ هو من فعل الغير والتكليف بفعل الغير تكليف بما لا يطاق
فإذا ما يقع به التكليف إنما هو ما ينسب إلى فعل العبد واكتسابه وليس ذلك
مرادا لله تعالى ولا داخلا تحت قدرته غير صحيح على ما سيأتي تفصيل القول
فيه إن شاء الله وأما ما ذكروه من المحال الرابع
فمبنى على فاسد
قولهم إن ما سبق من الإرادة لا يكون إلا عزما مع سبق فكر وتردد ولا يخفى
ما به من التحكم وهو وإن أمكن تخيله في الشاهد فإنه غير لازم في حق الغائب
كما سلف
وما قيل من أنه لا حاجة إلى صفة الإرادة مع وجود العلم
والقدرة فممتنع إذ القدرة هي ما يتأتى بها الإيجاد ولا محالة أن نسبتها
إلى سائر الأوقات نسبة واحدة فتخصيصها للحادث بزمان حدوثه من غير مخصص مع
ان نسبة الأوقات إليها نسبة واحدة لا معنى له وهو كما قيل في التخصيص
بالذات من غير فرق وهذا لا ينعكس في الإرادة كما سلف فإذا لا بد من المخصص
ثم لو أغنت عن الإرادة لحصول الإيجاد بها لأغنت عن العلم أيضا وكيف وأن
القدرة عند الخصم في الشاهد ما يتأتى بها الإيجاد كما في قدرة المختارين
بالنبسة إلى أفعالهم ومع هذا ليست كافية عن الإرادة حتى إن من كان قادرا
ولم يكن مريدا ! فإنه وان حصل الإيجاد في حقه صح ان يقال ليس هو أولى من
عدمه وان فعله عبث فهلا قيل مثله في حق البارى تعالى
وليس العلم مما
يصح الاكتفاء به عنها أيضا وإن لزم الحدوث في وقت الحدوث من ضرورة تعلق
العلم به إذ العلم لا يحصل به التمييز ومع قطع النظر عما به التمييز
فتخصيص الحادث بزمان حدوثه إذ ذاك لا يكون اولى به من غيره ثم إنه لو
اكتفى به عن الإرادة لضرورة وقوع الحادث على وفقه لاكتفى به عن القدرة
أيضا لهذا المعنى كيف وأنه من الجائز أن يحصل العلم في الشاهد لبعض
المختارين بإخبار صادق بأنه سيفعل كذا على كذا في وقت كذا ومع ذلك
فالإرادة لا تكون مستغنى عنها فقد بان من هذا أنه لا سبيل إلى القول
بالإستغناء بالعلم أو القدرة عن الإرادة أصلا ولا جائز أن يقال بأن معناها
هو معنى العلم أو القدرة إذ هما أعم منها من حيث أن كل مراد الله تعالى
مقدور ومعلوم وليس كل معلوم أو مقدور مرادا والقول بأن الأخص هو الأعم
والأعم هو الأخص محال
فقد بان انه لا بد من صفة زائدة على ذات
واجب الوجود يتأتى بها التخصيص بالحدوث وتلك الصفة هي الإرادة وأنها لا بد
من قدمها وأزليتها وقيامها بذات واجب الوجود وتعلقها بجميع الكائنات وهى
مع ذلك متحدة لا كثرة فيها ومع اتحادها فلا نهاية لها لا بالنظر إلى ذاتها
ولا بالنظر إلى متعلقاتها
أما بيان كونها واحدة فقد قال بعض الأصحاب
لو كانت متعددة لكان تعددها بتعدد متعلقاتها وما يصح أن تتعلق به الإرادة
غير متناه تقديرا فلو تعددت بتعدده لكانت غير متناهية اعدادها تحقيقا وقد
قام الدليل على استحالة ذلك وإن تعددت بسبب تعلقها ببعض المتعلقات
التقديرية فذلك يستدعى مخصصا والقديم لا تخصص له بجائز دون جائز
واعلم أن هذا غير صواب فإن ما ذكره من القسم الأول فمبنى على القول
بامتناع وجود أعداد لا نهاية لها وهي موجودة معا ولا ترتب لها وضعا ولا
طبعا وقد بينا وجه فساده فيما مضى وما ذكره من القسم الثاني فهو مع ما فيه
من التحكم كاذب في دعواه بجهة العموم والشمول استحالة تعلق القديم ببعض
المتعلقات الجائزة دون البعض فإن الممكنات منها ما هو مراد عنده ومنها ما
هو غير مراد والإرادة قديمة عنده لا محالة مع هذا التخصيص
فالرأي
الحق أن يقال لو كانت متعددة ومتكثرة لم تخل تلك المتكثرات إما أن تختلف
من كل وجه او تتحد من كل وجه أو تتحد من وجه وتختلف من آخر فإن اتحدت من
كل وجه فلا محالة أن الإرادة التي أردناها ليست إلا واحدا منها والباقي
ليس إرادة وإن اختلفت من كل وجه فليس التكثر فيها في صفة الإرادة لضرورة
أن حقيقة الإرادة ليست إلا حقيقة واحدة وإن اختلفت من وجه دون وجه فما به
التكثر والاختلاف حينئذ لا بد أن يكون خارجا عن صفة الإرادة وإلا فهو
القسم الاول بعينه وعند ذلك فما اختص بكل واحد من المتكثرين إما أن يكون
اختصاصه به لذاته أو باعتبار مخصص خارج لا جائز أن يقال بالاول وإلا لما
وقع الاختلاف فيه بين أعداد الإرادات إذ لكل تحت إرادة واحدة ولا جائز أن
يقال بالثاني وإلا فالمخصص له بذلك إما أن يكون بالذات او الإرادة فإن كان
بالذات فهو أيضا محال وإلا بما تخصص به احد المتماثلين دون الآخر إذ لا
أولوية وإن كان ذلك بالإرادة فالكلام في تلك الإرادة وما به تميزت كالكلام
في الأول وذلك يفضى إلى التسلسل وهو ممتنع
فإن قيل إضافة التخصيص
إلى ما يقتضيه لذاته وإن كان ممتنعا فلا يخفى ان الإرادة عبارة عما يتأتى
بها التخصص وإذ ذاك فلا فرق بينها وبين ما هو قائم بها أو بغيرها فعلى هذا
غير ممتنع أن يضاف التخصيص لما يخصص به كل واحد من أقسام الإرادة نفسه
ويكون تخصيصه له لا لذاته بل على النحو المفهوم من تخصيصه لما هو خارج عنه
وعند ذلك فليس يلزم الاشتراك على ما لا يخفى بل ويجوز أن يكون تخصص كل
واحد بما يخصص به مضافا إلى الآخر والتسلسل على هذا يكون منقطعا
قلنا أما الأول فمما لا يتجه اذ شرط التخصيص بالإرادة أن تكون
مخصصة
بالوجود وهذا مما لا يتم بدون ما قيل إنه مميز لها و مخصص وهو دور ممتنع
وعلى هذا يظهر امتناع ما قيل به ثانيا فإنه كيف يتصور أن يكون كل واحد من
أقسام الإرادة مخصصا للآخر وهو إنما يكون مخصصا لغيره بعد القول بتخصصه
وهو أيضا دور محال كيف وأن ذلك يفضى إلى إثبات صفات لنفس واجب الوجود
خارجة عنها ليست من الصفات النفسية من غير دليل عقلى ولا نص شرعى وهو محال
وهذه المحالات كلها إنما لزمت من فرض كون الصفة الإرادية متكثرة
كيف
وأن الطريق الموصل إلى ثبوت صفة الإرادة إنما هو كون الكائنات وذلك إنما
يدل على أنه لا بد من إرادة يكون بها التخصيص والقول بتعددها مما يزيد على
القول الواجب من غير دليل فإنه لا مانع من أن تكون الإرادة واحدة
والمتعلقات متعددة وذلك على نحو تعلق الشمس بما قابلها واستضاء بها فإنه
وإن كان متعددا لا يوجب تعددها في نفسها وإن أوجب تعدد متعلقاتها على ما
لا يخفى وهذا هو الأقرب إلى الإنصاف والأبعد عن الاعتساف من جهة أن العقل
قد دل على وجود اصل الإرادة فالقول بنفيها تقصير والقول بتكثرها إفراط وكل
خارج عن حوزة الاحتياط
ولعمري إن من رام نفى التكثر من صفة الإرادة أو غيرها من الصفات بغير ما
سلكناه لم يجد فيه كلاما محصلا
فإن قيل قولكم إن ما وقع به التعدد والاختلاف إن كان خارجا عن حقيقة صفة
الإرادة فلزم إثبات صفات للذات خارجا عن اصل الإرادة فإنما يستقيم أن لو
لم يصح التغاير بين الذوات إلا باعتبار صفات وجودية وامور حقيقة وما
المانع
من أن التغير بين الذوات باعتبار سلوب وإضافات ومتعلقات
خارجة عن الذوات بأن يكون متعلق كل واحد غير متعلق الأخرى مما نسب إليها
أو سلب عنها وتلك ليست امورا وجودية ولا صفات حقيقية وذلك على نحو ما
يقوله الفيلسوف في وجوب تكثر الانفس الإنسانية عند مقارنة الأبدان وبعد
مفارقتها أيضا فإن السبب الموجب للتكثر ليس إلا ملابسة النفس البدن
واختصاصها بالنظر الى احواله وتدبيره لا ان اختصاصها به اختصاص الصفات
بالموصوفات وأن ما حصل لها من النسبة من حالة المقارنه هو الذي أوجب
بقاءها متغايرة بعد المفارقة فعلى هذا غير بعيد أن يكون التغاير بين
الإرادات المتكثرة باعتبار النسب والإضافات وتغير المتعلقات
قلنا قد
بينا أن الاختلاف يستدعي مميزا وما قيل من أنه يجوز أن يسند ذلك إلى
السلوب والإضافات فمندفع وذلك أن السلب عن أحد المتكثرين إن وقعت بينهما
المشاركة فيه بأن يكون مسلوبا عن كل واحد منهما كسلب الحجر عن الإنسان
والفرس فذلك ما لا يوجب الاختلاف وإن لم تقع المشاركة بينهما فيه بأن يكون
ما سلب احدهما موجبا للآخر ففيه إثبات صفة زائدة وهو عود إلى ما ابطلناه
وأما التغاير باعتبار الإضافة والتعلق فتلك الإضافات والتعلقات أما أن
توجب قيام صفات بالمتعلقات أو ليس فإن أوجبت قيام صفات بالمتعلقات فهو وإن
أوجب التغاير لكنه فيما نحن فيه متعذر لما بينا وإن لم يوجب قيام صفات
بالمتعلقات فهي غير موجبة للتغاير في التعلق أصلا بل يجوز أن يتحد الشئ
إتحادا مطلقا
وإن اختلفت إضافتة ونسبته إذا لم تجب له من تلك الإضافات صفات
زائدة على ذاته وهذا مما لا خفاء به
وعلى هذا الحقيق فالإرادة صفة واحدة لا انقسام فيها لا بالحد ولا بالكم
وإن وقع التعدد في متعلقاتها وتعلقها وذلك على نحو ما ذكرناه من تعلق
الشمس بما قابلها واستضاء بها فإنه وإن كان متعددا أو متغايرا لا يوجب
وقوع التعدد في الشمس نفسها وهو المعنى بسلب النهاية عن ذات واجب الوجود
وكذا في غير الإرادة من صفات الذات وأما سلب النهاية عنها بالنظر إلى
متعلقاتها فليس المعنى به أيضا إلا ان ما يصح ان تتعلق به الإرادة من
الجائزات لا نهاية له بالقوة لا انه غير متناه بالفعل
وهذا مما لا مراء فيه ولا دليل ينافيه وهذا آخر ما أردنا ذكره ههنا والله
الموفق للصواب
الطرف الثاني
في اثبات صفة العلممذهب أهل الحق أن البارى تعالى عالم بعلم واحد قائم بذاته قديم أزلى متعلق بجميع المتعلقات
وأما الفلاسفة فمختلفون
ا فمنهم من نفى عنه العلم مطلقا ولم يجوز أن يكون له علم متعلق بذاته ولا بغيره
ب ومنهم من أوجب له ذلك لكن منع أن يكون متعلقا بغيره بل بذاته
ج ومنهم من جوز عليه ذلك لكن بشرط كون المتعلق كليا واما الجزئيات فإن تعلق بها فليس ذلك إلا على نحو كلى لا أنه متعلق بالجزئى من حيث هو جزئى
وأما المعتزلة فموافقون على العالمية دون العلمية كما مضى تفصيل مذهبهم
وأما الجهمية فقد ذهبوا إلى أنه عالم بعلم قائم لا في محل وهو مع ذلك متجدد بتجدد الحادثات متعدد بتعدد الكائنات
وعند ذلك فلا بد من إيضاح السبيل إلى زيف مذاهب أهل التعطيل
أما على رأي الإلهيين فإنه لما انحسم على من أثبت كونه عالما طريق التوصل
إليه بتوقف تخصيص الجائزات عليه كما سبق وصفه من مذهبهم ولم يمكنه
الاسترواح إلى ما استروح إليه المتكلمون أهل الحق لمناقضات تلزمه انتهج في
ذلك منهجا غريبا وهو أنه زعم أن الوجود من حيث إنه طبيعة الموجود غير
ممتنع عليه أن يعلم ويعقل وإنما يعرض له أنه لا يعلم ويعقل بسبب صاد ومانع
راد وهو كونه في المادة ومتعلقا بعلائق المادة وكل وجود مجرد عن المادة
وعلائقها فغير ممتنع عليه أن يعلم وهو وإن كان متوهما غير سديد وما قيل من
أن طبيعة الوجود غير ممتنع عليها أن تعقل فلا محالة أن إطلاق لفظ الوجود
على واجب الوجود وعلى غيره ليس إلا بطريق الاشتراك لا بالتواطؤ وإلا كان
مشاركا لها في طبيعتها ويلزم أن تكون ذات واجب الوجود ممكنة مفتقرة إلى
مرجح خارج وهو محال فعلى هذا إن أريد بلفظ الوجود كل مدلولاته بحيث تكون
ذات واجب الوجود مندرجة فيه وداخلة تحته فدعوى مجردة وإدراج لمحل النزاع
في كلية ما صادر على كونه مسلما ولا يخفى ما فيه من الزيف فإنه لو سلم أنه
غير ممتنع أن يعلم لوجب أن يكون العلم له إما واجبا وإما ممكنا والإمكان
منتف عن ذاته عنده مطلقا فبقى أن يكون واجبا وذلك محل النزاع
وإن
أريد به طبيعة كل موجود سوى واجب الوجود فمع بعده غير مفيد ولا مؤد
للمقصود إذ الحكم على القضية الجزئية بمثل ما حكم به على الكلية إنما يلزم
أن لو كانت الجزئية داخلة فيها وليس كذلك وإن زال المانع فغير مفيد لعدم
القبولية والاقتضاء معا ثم ومع التقدير بكونه عالما فلا معنى للخوض في
التفصيل
بين ذاته وباقى الذوات ولا بين الكليات والجزئيات كما سنبينه
فالحق ان مبدأ النظر في مبدأ أهل الحق مستمد من التخصيص والتمييز بصفة
الأرادة ومع ثبوت ذلك فالمتميز إما أن يكون محاطا به أو غير محاط به
لا يجائز ان يكون غير محاط به والا لما تصور تمييزه عن غيره فإذا لا بد من
الإحاطة به ثم كيف ينكر ذلك والعقل الصريح يقضى بيديه بأن صدور ما هو على
غاية من الإحكام والاتقان عمن لا إحاطة له محال كيف وأنه لو لم يكن متصفا
بالعلم لكان ناقصا بالنسبة إلى من له العلم من مخلوقاته كما سبق بيانه وهو
محال
وعند لزوم هذا العلم له إما أن يكون معنى عدميا او لا وجوديا ولا عدميا
وإما أن يكون وصفا وجوديا
لا جائز أن يقال بكونه عدميا إذ لا فرق بين قولنا إنه لا علم له وبين
قولنا إن علمه معنى عدمى كيف و أن من فهم مدلول هذه اللفظة لم يجد من نفسه
أن فهمه لأمر سلبى عدمى ألبته
ولا جائز أن يقال بأنه لا موجود ولا
معدوم إذ هو مبنى على القول بالأحوال وقد أبطلناها وإذ ذاك فلا بد من أن
يكون معنى وجوديا وهو مع ذلك قديم أزلى قائم بذات الرب تعالى متعلق بجميع
الكائنات متحد لا كثرة فيه غير متناه
بالنظر إلى ذاته ومتعلقاته
وبيان ذلك على نحو بيانه في الإرادة وقد عرف فلا حاجة إلى إعادته لكن ربما
أشكل وجه استعمال ما ذكرناه في بيان اتحاد الإرادة في العلم والسبيل فيه
أن يقال بعد إبطال الاقتضاء للتخصيص بالذات وتعين الاقتضاء بالقدرة
والارادة فإن شرط هذا الاقتضاء تعلق العلم بالمقتضى كما سلف وإذ ذاك فإما
أن يكون كل واحد من اقسام العلم هو المتعلق بما تخصصه القدرة والأرادة او
غيره فإن كان هو فهو انما يتم تعلقه بغيره أن لو كان متخصصا بالوجود وذلك
يفضى إلى الدور كما دار في الإرادة وإن كان غيره لزم منه التسلسل او الدور
كما حققناه في الإرادة وهو أيضا ممتنع
والذي يخص هذا الطرف من
التشكيكات ويتجه عليه من الخيالات قولهم لو كان له علم لما خرج عن أن يكون
ضروريا أو نظريا وأن يكون تعلقه بالمعلومات على نحو تعلق علومنا بها ويلزم
إذ ذاك الاشتراك بين العلم الحادث والقديم في الحقيقة لضرورة اشتراكهما في
أخص صفات العلم الحادث وذلك في حق واجب الوجود محال ثم ولو قدر كونه عالما
فما المانع من أن يكون تعلقه بذاته دون غيره وبم الرد على من زعم ذلك وقال
لو علم غير ذاته لم يخل إما أن يكون علمه بذاته هو علمه بغيره أو هما
متغايران لا جائز أن يكونا واحدا إذ العقل يقضى بإبطاله ولا جائز أن يكونا
متغايرين وإلا لزم التعدد في علم البارى تعالى وهو محال ثم لو
قدر
تعلقه بغيره فما المانع من أن يكون ذلك مختصا بالكليات دون الجزئيات وبم
الرد على من ابطل ذلك وزعم أنه لو كان علم البارى متعلقا بالجزئيات
الكائنات الفاسدات لم يخل عند تعلقه بها إما أن يكون سابقا عليها او حادثا
ومتجددا بتجددها لا جائز أن يكون أوليا وإلا كان ذلك جهلا لا علما وإن كان
حادثا فهو إما أن يكون في ذاته او في غير ذاته وعلى كل تقدير فهو محال لما
سبق وأيضا فإنه إما أن يكون العلم بالكائنات عبارة عن انطباع صورها في
النفس أو عبارة عن إضافة تحصل بينها وبينه فإن كان الأول لزم أن يكون ذات
واجب الوجود متجزئة لانطباع المتجزئ فيها كما يأتي وإن كان الثاني فالعلم
إذ ذاك إما قديم أو حادث لا جائز ان يكون قديما وإلا لوجب أن يكون الحادث
الذي تعلق به قديما لضرورة أن الإضافة لا تحصل إلا بين شيئين والقول بقدم
الحادثات محال وإن كان حادثا فهو محال أيضا كما سبق
ومستند ضلال
الجهمية في القول بحدوث علم البارى تعالى لا في محل وتجدده بتجدد
المعلومات وتكثره بتكثرها ليس إلا هذه الخيالات والاعتماد على هذه
التمويهات والكشف عن وجه الحق فيها متوقف على الانفصال عنها فنقول
قد قدمنا أنه لا بد أن يكون له علم وما قيل من إنه اما ان يكون بديهيا أو
نظريا فإنما ينفع أن لو تبين قبوله لهذا الانقسام وإلا فلا ومجرد القياس
على الشاهد في ذلك مما لا يفيد كما أسلفناه ثم إن البديهي لا معنى له إلا
ما حصل من غير نظر ولا دليل ولا تصح مفارقته أصلا وهذا بعينه ما ثبت للرب
تعالى وإن لم يصح إطلاق اسم البديهة عليه من جهة الشرع لعدم وروده به
فالمنازعة إذا ليست الا في إطلاق اللفظ لا نفس المعنى ولا حاصل له اللهم
إلا أن يعنى بالبديهية غير ما ذكرناه
والاشتراك بين العلم القديم
والحادث إنما يلزم أن لو اشتركا فيما هو أخص صفة لكل واحد منهما أو
لأحدهما وليس كذلك بل صفة العلم الربانى وجوب تعلقه بسائر المعلومات من
غير تأخر على وجه التفصيل وأخص وصف العلم الحادث جواز تعلقه بالمعلومات لا
نفس وقوع التعلق ولا يخفى إذ ذاك انتفاء الاشتراك بينهما ثم إن ذلك لازم
على المعتزلى في العالمية أيضا إذ نسبة العالمية إلى العلمية على نحو نسبة
العلم إلى العلمية
وما قيل من أنه لو تعلق علمه بذاته وبغير ذاته
لاتحدا أو تغايرا وهما محالان ففاسد إذ لا مانع من أن يكون العلم في نفسه
واحدا ومتعلقاته مختلفة ومتغايرة
وهو متعلق بكل واحد منهما على نحو
تعلق الشمس بما قابلها واستضاء بها بل وعلى نحو ما يقوله الخصم في العقل
الفعال لنفوسنا فإنه متحد وإن كانت متعلقاته متكثرة ومتغايرة
وما
اعتمد عليه في إختصاص التعلق بالكليات دون الجزئيات فباطل أيضا فإن تعلق
العلم بالكائنات مما لا يوجب تجدد العلم ولا الجهل من سبقه إذ السابق هو
العلم بأن سيكون والعلم بأن سيكون الشئ هو نفس العلم بكونه في وقت الكون
من غير تجدد ولا كثرة وإنما المتجدد هو نفس المتعلق والتعلق به وذلك مما
لا يوجب تجدد
المتعلق بعد سبق العلم بوقوعه في وقت الوقوع وفرض
استمراره إلى ذلك الوقت فإنا لو رفعنا كل علم حادث من النفس لم يكن في حال
حدوثه غير معلوم وإلا كان العلم بأن سيكون في وقت كونه مع القول بفرض
استمراره جهلا وهو محال
ولهذا إن من علم بالجزم بأن سيقوم زيد مثلا
في الوقت الفلانى فإنه لا يجد نفسه محتاجة إلى علم متجدد بوقوعه في ذلك
الوقت اذا انتهى اليه وفرضنا بقاء علمه السابق الى ذلك الوقت وما يجده
الإنسان من نفسه من التفرقة بين قبل الكون وبعده فإنما هو عائد إلى
إدراكات حسية وأمور خارجية عن العلم لم تكن قبل الكون أما في نفس العلم
فلا بل غاية ما يقدر ان تعلق العلم به عند الكون لم يكن متحققا قبل الكون
وغاية ما يلزم ذلك انتفاء تعلق العلم بوجوده في حال عدمه وتجدد التعلق به
في حال الوجود وذلك مما لا يلزمه القول بحدث صفة العلم بل العلم قد يكون
قديما وإن كان ما له من التعلقات والمتعلقات متجدده ومتغيرة بناء على تجدد
شروط التعلق وتغيرها
كيف وأن هذا مما لا يتجه من الخصم سواء كان
نافيا كالمعتزلى والفلسفى أو مثبتا له حادثا كالجهمى وذلك لأن سبق العلم
بوجود الشئ في حالة عدمه إن كان جه والجهلا قبيح فلا محالة ان القول
بانتفاء العلم به أيضا جهل ويلزم أن يكون قبيحا وليس انتفاء العلم أصلا
ورأسا كما ظنه النفاة أو انتفاء قدمه كما ظنه الجهمى لضرورة دفع ما يتحصل
من تحقق الجهل بأولى من إثباته والقول بقدمه دفعا لما يلزم من الجهل ولا
محيص عنه وما يخص المعتزلة من النفاة لزوم ما ألزموه عليهم في العالمية
حيث قضوا بكون البارى تعالى عالما في القدم وعند ذلك فإما ان يكون عالما
بوجود الحادث قبل حدوثه أو تجددت له العالمية بتجدد الحادث وعلى كل تقدير
فما هو جواب لهم في حكم العلم هو جواب لنا في نفس العلم
وما يخص
الجهمية هو أن يقال ولو كانت العلوم الربانية حادثه فتلك العلوم إما أن
تفتقر إلى علوم تتعلق بها في حال حدوثها او لا تفتقر لا جائز ان يقال
بالأول وإلا أفضى إلى التسلسل وهو محال ولا جائز أن يقال بالثانى إذ لو
استغنت عن تعلق العلم بها مع كونها حادثا لكان كل حادث هكذا كيف وأن عند
الخصم ان العلم الحادث سابق على المعلوم بشئ يسير وكل علم سابق كان السبق
متناهيا أو غير متناه فإنه علم ما سيكون لا علم بالكون إذ العلم بالكون
قبل وقته يمتنع وعند هذا فلا فرق بين ان يكون حادثا او قديما فيما يرجع
إلى نفس ما أوردوه من الإلزام وليس تعلق العلم بالعلوم عبارة عن انطباع
صورة المعلوم وشكله في نفس العالم به وإلا لما تصور القول بتعلق السواد
والبياض معا لما فيه من القول باجتماع الضدين في محل واحد وليس الاستحالة
في اجتماعها منوطة بالحدث والوجود العينى فإن ذلك مما لا يوجب التضاد
لكونه قضية واحدة لا اختلاف فيها فإذا ليس التضاد إلا لما أمكن تعلقه من
معنى السواد والبياض وما يلتحق بكل واحد منهما مما يكون به الاشتراك
بينهما في حالة الوجود العينى
كيف وأنه لو كان التعلق هو الانطباع
لما تصور أيضا أن يتعلق العلم بما يزيد في الكم على محل الانطباع ثم إن
ذلك إنما يستند إلى أصل فلسفى وهو مناقض لأصله في ذلك من جهة قضائه بإدراك
القوة الوهمية بآلة جرمانية لما لا تجزى له في نفسه وليس بمادى وذلك على
نحو إدراك الشاة للمعنى
الموجب لنفرتها عن الذئب فلو كان التعلق
هو نفس الانطباع فكما يستحيل انطباع المتجزى فيما لا تجزى له فكذا يستحيل
انطباع غير المتجزى في المتجزي فليس التعلق إذا إلا عبارة عن معنى إضافى
يحصل بين العلم والمعلوم وذلك مما لا يستدعي كون المعلوم معنى وجوديا ولا
أمرا حقيقيا وإلا لما جاز تعلق العلم باستحالة اجتماع الضدين
وبانتفاء كون الجسم الواحد في آن واحد في مكانين ولا بانتفاء الشريك لواجب
الوجود على ما لا يخفى ثم إن ذلك مما يلزم الخصوم من المعتزلة في اعتقادهم
قدم العالمية كما سلف
والله ولى التوفيق
الطرف الثالث
في اثبات صفة القدرةويجب أن يكون البارى تعالى قادرا بقدرة لضرورة ما أسلفناه من البيان واوضحنا من البرهان في مسألة العلم و الإرادة ويجب أن تكون صفة وجودية قديمة أزلية قائمة بذات الرب تعإلى متحدة لا كثرة فيها متعلقة بجميع المقدورات غير متناهية بالنسبة إلى ذاتها ولا بالنظر إلى متعلقاتها لما حققناه
وليست القدرة عبارة عما يلازمه الإيجاد بل ما يتأتى به الإيجاد على تقدير تهيئه من غير استحالة ذلك على نحو ما في التمييز والتخصيص بالإرادة وبه يتبين فساد قول من ألزم الإيجاد بالقدرة القديمة على من نفى الإيجاد بالذات حيث ظن أن القدرة القديمة يلازمها الإيجاد لا ما يتأتى بها الإيجاد وإن لم يلازمها
فإن قيل كيف تدعون أن كل ممكن مقدور لله تعالى وأكثر أفعال الحيوانات بأسرها مقدورة لها كما سيأتى وإذ ذاك فلو كانت مقدورة لله تعالى للزم أن يكون مقدور بين قادرين وذلك ممتنع كما يأتى أيضا وأيضا فإن أكثر الموجودات متولدة بعضها عن بعض وهكذا ما نشاهده من تولد حركة الخاتم ضد حركة اليد وكذا في حركة كل متحرك بحركة ما هو قائم به وملازم له فإنه لا يمكن أن يقال إن حركة الخاتم مخلوقة لله تعالى وإنها غير تابعة لحركة اليد وإلا لجاز أن يخلق حركة أحدهما مع سكون الأخرى وهو لا محالة ممتنع
والجواب أما ما ذكروه من الشبهة الاولى فسيأتى الجواب عنها في
مسألة خلق الأفعال إن شاء الله تعالى
وأما ما ذكروه من الشبهة الثانية فإنهم إن أرادوا بالتولد ههنا أن الحركة
التي للخاتم كامنة في حركة اليد وهي تظهر عند حركة اليد منها كما يظهر
الجنين في بطن أمه وكما في كل ما يتوالد فهو الفهوم من لفظ التوالد لكنه
ها هنا غير مشاهد كما ادعوه ولا متصور أيضا بل الشاهد المتصور ليس إلا
لزوم حركة الخاتم لحركة اليد فإن أريد بالتولد هذا فلا مشاحة في التسمية
وإن كانت بالنسبة إلى الاصطلاح الوضعى خطأ لكنه مع ذلك مما لا يلزم أن
يكون وجوده عن وجود حركة اليد بل من الجائز أن يكون موجودان احدهما يلازم
الآخر إما عادة كملازمة التسخين للنار والتبريد للماء والأفيون وإما
اشتراطا كملازمة العلم للإرادة والحياة للعلم وليس ولا احدهما مستفادا من
الآخر بل كلاهما مخلوقان لله تعالى وبهذا يندفع ما ذكروه من أنه لو كان
اللازم مخلوقا لله تعالى لجاز خلق أحدهما مع سكون الآخر كيف وأنه كما
تتوقف حركة الخاتم على حركة اليد تتوقف حركة اليد على حركة الخاتم حتى إنه
لو فرض عدم انتقال الخاتم عن مكانه كان القول بحركة اليد مستحيلا فعلى هذا
ليس جعل حركة اليد علة لحركة الخاتم لتوقفها عليها بأولى من العكس بل
الواجب أنهم معلولان لعلة واحدة وإن قدر تلازمهما في الوجود
وعند هذا فلا بد من الإشارة إلى دقيقة وهي أن ما علمه الله تعالى
أنه لا يكون منه ما هو ممتنع الكون لنفسه وذلك كاجتماع الضدين
وكون الشئ
الواحد في آن واحد في مكانين ونحوه ومنه ما هو ممتنع الكون لا باعتبار
ذاته بل باعتبار أمر خارج وذلك مثل وجود عالم آخر وراء هذا العالم أو قبله
فما كان من القسم الأول فهو لا محالة غير مقدور من غير خلاف وما كان من
القسم الثانى وهو أن يكون ممتنعا لا باعتبار ذاته بل باعتبار تعلق العلم
بأنه لا يوجد أو غير ذلك فهو لا محالة ممكن باعتبار ذاته كما سلف والممكن
من حيث هو ممكن لا ينبو عن تعلق القدرة به والقدرة من حيث هي قدرة لا
يستحيل تعلقها بما هو في ذاته ممكن إذا قطع النظر عن غيره إذ الممكن من
حيث هو ممكن لا ينبو عن تعلق القدرة به والقدرة من حيث هى قدرة لا تتقاصر
عن التعلق به لقصور فيها ولا ضعف
فعلى هذا الممكن صالح أن تتعلق به
القدرة من حيث هو كذلك ولا معنى لكونه مقدورا غير هذا وإطلاق اسم المقدور
عليه بالنظر إلى العرف وإلى الوضع باعتبار هذا المعنى غير مستبعد وإن كان
وجوده ممتنعا باعتبار غيره وأما إن أريد به أنه غير مقدور بمعنى أنه يلزم
منه المحال باعتبار أمر خارج أو أنه لم تتعلق به القدرة بمعنى أنها لم
تخصصه بالوجود بالفعل فهو وإن كان مخالفا للاطلاق فلا مشاحة فيه إذ
المنازعة فيه لا تكون إلا في إطلاق اللفظ لا في نفس المعنى والله ولى
التوفيق
الطرف الرابع
في اثبات صفة الكلامذهب أهل الحق من الإسلاميين إلى كون البارى تعالى متكلما بكلام قديم ازلى نفسانى احدى الذات ليس بحروف ولا اصوات وهو مع ذلك ينقسم بانقسام المتعلقات مغاير للعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات
وأما أهل الأهواء المختلفون فمنهم نافون للصفة الكلامية ومنهم مثبتون
ثم المثبتون منهم من زعم ان كلام الرب تعالى عن قول الزائغين مركب من الحروف والأصوات مجانس للأقوال الدالة والعبارات كالمعتزلة والخوارج والإمامية وغيرهم من طوائف الحشوية
ثم اختلف هؤلاء فذهب الحشوية إلى أنه قديم أزلى قائم بذات الرب تعالى وذهب النافون إلى انه حادث موجود بعد العدم قائم لا في محل لكن منهم من لم يجوز إطلاق اسم الحدث عليه مع كونه يقطع بحدثه ومنهم من لم يتحاش عن ذلك
ومن المثتبين من زعم أن الكلام
قد يطلق على القدرة على التكلم وقد يطلق على الأقوال والعبارات وعلى كلا
الاعتبارين فهو قائم بذات الرب تعالى لكن إن كان بالاعتبار الأول فهو قديم
متحد لا كثرة فيه وإن كان بالاعتبار الثاني حادثا متكثرا
هؤلاء هم الكرامية ومنه تابعهم من اهل الضلال
ونحن الآن نبتدئ بذكر طرق عول عليها العامة من المتكلمين في إثبات الكلام
وننبه على مواضع الزلل فيها ثم نوضح بعد ذلك الاجود من الجانبين ونكشف عن
مستند الطائفتين إن شاء الله
فمن جملة ما اعتمد عليه أن قالوا العقل
الصريح يقضى بتجويز تردد الخلق بين الأمر والنهى ووقوعهم تحت التكليف فما
وقع فيه التردد إما قديم أو حادث فإن كان قديما فهو المطلوب وإن كان حادثا
فكل صفة حادثة لابد أن تكون مستندة إلى صفة قديمة للرب تعالى قطعا للتسلسل
وإذا كان ذلك وجب أن يستند تكليفهم إلى أمر ونهى هو صفة قديمة للرب تعالى
وهذا ما لا يصح التعويل عليه وذلك أنه إما أن يدعى أن الخلق جائز تكليفهم
وترددهم بين الامر والنهى من الخالق أو من المخلوق فإن كان الأول فهو عين
المصادرة على المطلوب وإن كان الثاني فغير مفيد ولا مجد للمقصود ولا يلزم
من كون ما وقع به التكليف من الاوامر والنواهى جائزا أن يستند إلى صفة
قديمة أن تكون أمرا ونهيا حتى لا يكون أمر حادث إلا عن أمر ولا نهى إلا عن
نهى فإن افتقار الجائز في الوجود لا يدل إلا على ما يجب الانتهاء إليه
والوقوف عليه ولا دلالة له على كونه أمرا أو نهيا ومن رام إثبات ذلك فقد
كلف نفسه شططا
ثم لو وجب ذلك لكان البارى تعإلى مصنفا بمثل كل ما وجد في عالم
الكون والفساد من الكائنات وذلك محال
ولهذا انتهج بعض الأصحاب في الإثبات طريقا اخر فقال قد ثبت كون البارى
تعالى عالما ومن علم شيئا يستحيل أن لا يخبر عنه بل العلم والخبر متلازمان
فلا علم إلا بخبر ولا خبر إلا بعلم وهو من النمط الأول في الفساد فإنه إن
ادعى ذلك بطريق العموم والشمول في حق الخالق والمخلوق فهو نفسه مصادرة على
المطلوب ولا يخفى ما فيه من الركاكة والفهاهة وإن ادعى ذلك في حق المخلوق
فقط فإنه وإن سلم مع إمكان النزاع فيه فليس بحجة في حق الغائب على ما سلف
ولربما وقع الاعتماد ههنا ايضا على الطريق المشهور وهو أن البارى تعالى حي
فلو لم يكن متصفا بالكلام لكان متصفا بضده وهو الخرس وذلك في البارى تعالى
نقص وقد نبهنا على ما فيه من الخلل وأشرنا إلى ما يتضمنه من الزلل فيما
سلف فلا حاجة إلى إعادته
ولما تخيل بعض الأصحاب ما في طى هذه
المسالك من الزيف واستبان ما في ضمنها من الحيف جعل مستنده في ذلك جملا من
الأحاديث الواردة من السنة وأقاويل الأمة وهى مع تقاصرها عن ذروة اليقين
وانحطاطها إلى درجة الظن والتخمين من جهة المتن
والسند فالأحتجاع
بها إنما هو فرع إثبات الكلام إذ مستند قول الأمة ليس إلا قول الرسول
والرسول لا معنى له إلا المبلغ لكلام المرسل فإذا لم يكن للمرسل كلام لم
يكن من ورد الامر والنهى على لسانه رسولا بل هو الآمر والناهى وسواء كان
ذلك مخلوقا له او لغيره على اختلاف المذاهب ولا يكون ذلك حجة وصار كما في
الواحد إذا أمر غيره أو نهاه فإذا حاصل الأستدلال على ثبوت الكلام يرجع
إلى ما الاحتجاج به فرع ثبوت الكلام وهو دور ممتنع ولا حاصل له عند منكرى
النبوات وجاحدى الرسالات
فإذا ما هو أقرب إلى الصواب في هذا الباب
إنما هو الاعتماد على ما وقع عليه الاعتماد أولا من إثبات الصفات السابقة
ثم كيف لا يكون له كلام وبه يتحقق معنى الطاعة والعبودية لله تعالى فإن من
لا أمر له ولا نهى له لا يوصف بكونه مطاعا ولا حاكما وبه أيضا يتحقق معنى
التبليغ والرسالة فإنه لا معنى للرسول إلا المبلغ لكلام الغير فلو لم يكن
لله تعالى كلام وراء كلام الرسول المخلوق فيه إما له عندهم أو لله تعالى
على أصلنا لما صح أن يقال إنه مبلغ ولا رسول ولكان كاذبا في دعواه أنى
رسول الله رب العالمين فيما امرت به ونهيت وذلك كالواحد منا إذا امر غيره
أو نهاه ولم يكن مبلغا عن الغير فإنه لا يسمى رسولا وذلك لازم في حق
المعترف بالنبوات المصدق بالرسالات لا محالة وإذا تحقق ما ذكرناه فلا بد
من الإشارة إلى الكشف عما يختص بهذا الطرف من شبه الجاحدين ومعتمد
المعطلين
أما الفلاسفة فإنهم قالوا ما ذكرتموه من الطريقة في إثبات الكلام فإنه
متوقف
على التصديق بكبراها وبم الرد على منكرها والجاحد لصدقها في
نفسها والذي
يدل على كذبها في نفسها أنه لو كان لله كلام لم يخل إما أن يكون من جنس
كلام البشر أو ليس فإن كان من جنس كلام البشر فهو محال وإلا لزم أن يكون
مشاركا لكلام البشر في جهة الإمكان والعرضية ويلزم أن يكوى البارى تعالى
محلا للأعراض وهو معتذر ثم ان كان من جنس كلام البشر فأما ان يكون من جنس
كلام اللسان أو مما في النفس فإن كان من جنس كلام اللسان فإما أن يكون
بحروف وأصوات أولا بحروف ولا أصوات او صوت بلا حرف او حرف بلا صوت
لا جائز أن يقال بالأول إذ الصوت لا يكون إلا عن اصطكاكات أجرام والحروف
هي عبارة عن تقطيع الأصوات وذلك يستدعى أن يكون البارى جرما وهو ممتنع ولا
جائز أن يقال بالثانى وإلا فهو خارج عن جنس اللسان فإن كلام اللسان عبارة
عن الأصوات مقطعة دالة بالوضع على غرض مطلوب وعلى هذا يمتنع تفسيره
بالثالث والرابع أيضا ثم كيف يكون الكلام حروفا بلا أصوات وليست الحروف
إلا عبارة عن تقطيع الأصوات أو كيف يكون الصوت كلاما من غير حرف وكيف يقع
الافتراق بينه وبين هبوب الرياح ودوى الرعود ونقرات الطبول ونحوه
هذا إن قيل إنه من جنس كلام اللسان وإن قيل إنه من جنس ما في النفس فذلك
لا يسمى كلاما ولو سمى كلاما فالمعقول من كلام النفس ليس خارجا عن القدرة
والإرادة والتمييز الحاصل للنفس الحيوانية والحواس الباطنية وذلك كما
تتصوره القوة الخيالية من شكل الفرس عن شكل الحمار ونحوه وما تتصوره القوة
الوهمية
للشاة من المعنى الذي يوجب نفرتها عن الذئب ونحوه أو
للتمييز الحاصل للنفس والناطقة الإنسانية بالقوة النظرية التى بها إدراك
الأمور الكلية بالفكرة والروية وذلك كتصورنا معنى الإنسان من حيث هو إنسان
وكحكمنا عليه بأنه حيوان ونحوه
فإن إريد به القدرة أو الأرادة فذلك
غير مباين لما أثبتموه أولا وإن إريد التمييز والتصور الحاصل للنفس
الحيوانية أو النفس الإنسانية فذلك أيضا غير خارج عن قبيل العلوم كيف وأنه
متعذر أن يراد به التمييز الحاصل بالحواس الباطنية فإن إدراكها لذلك لا
يكون صادقا إلا بأن تنطبع أولا الصورة المحسوسة الخارجية في إحدى الحواس
الظاهرة الخمسة ثم بتوسطها تنطبع في الحس المشترك وهي القوة المرتبة في
مقدم التجويف الأول من الدماغ على نحو انطباع الصور في الأجرام الصقيلة
المقابلة ثم بتوسطها في المصورة ثم في المفكرة ثم في الوهمية ثم في
الحافظة وبعض هذه القوى وإن لم يفتقر في الانطباع إلى حضور المادة كما في
المصورة والمفكرة والوهمية والحافظة فهى بأسرها لا تنفك عن الانطباع عن
علائق المادة وأن إدراكها لا يكون إلا بانطباع الأشكال والصور الجزئية
القابلة للتجزى وانطباع ما يقبل التجزى لا يكون إلا فيما هو قابل للتجزى
والبارئ يستحيل أن يكون متجزئا وأما إن أريد به غير هذا فهو تفسير له بما
ليس بمعقول وإن قيل إنه ليس من جنس كلام البشر فهو أيضا غير معقول وما ليس
بمعقول كيف نسلم كونه كمالا للرب تعالى وأن عدمه نقصان
وقولكم إنه
لو لم يكن له أمر ولا نهى لما تحقق معنى الطاعة لله تعالى ولما صحت
الرسالة فليس كذلك بل صحة ذلك تستند إلى التسخير على وجه الطواعية
والإذعان
على وفق الإرادة والاختيار فإن تسخيره للمخلوقات
وإبداعه للكائنات بلا آلات ولا أدوات وتقليب الخلائق بين اطوار المرغبات
والمنفرات على وجه الطواعية حالة تنزل منزلة القول بالأمر والنهى حتى لو
عبر عن تلك الحالة بالقول كان ذلك أمرا ونهيا وإليه الإشارة بقوله تعالى
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا
أتينا طائعين وليس ذلك عبارة إلا عن الانقياد والاستسخار إذ يتعذر أن يكون
ذلك خطابا في حق السماء أو قولا لها ولذلك قد يشتد صفاء بعض الناس بحيث
يقرب اتصالها بالعقول الكروبية والنفوس الروحانية بحيث يطلع على الأشياء
الغيبية من غير واسطة و لا تعلم يسمع من الأصوات ويرى من الصور ما لا يراه
من ليس من اهل منزلته من البشر على ما يراه النائم في منامه فتكون حالته
إذ ذاك نازلة منزلة ما لو أوحى إليه بأن الأمر الفلانى كذا وكذا ولا مشاحة
في الإطلاقات بعد انكشاف غور المعنى
واما المعتزلة فانهم لم يخالفوا
في كون البارى تعالى متكلما وفي أن له كلاما ولكنهم قالوا معنى كونه
متكلما وأن له كلاما أنه فاعل للكلام وذلك صفة فعلية لا صفة نفسية ثم كيف
يكون متكلما بمعنى قيام الكلام به ولو كان كذلك فالكلام لا محالة مشتمل
على أمر ونهى وخبر واستخبار ونحوه وهو إما أن يكون قديما أو حادثا فإن كان
قديما أفضى إلى إثبات قديمين وهو ممتنع كما سلف ثم إنه يفضى إلى الكذب في
الخبر من قوله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وقوله وإذ قال موسى
لقومه وقوله
كما قال عيسى ابن مريم للحواريين ونحو ذلك من حيث إن الخبر قديم والمخبر
عنه مخدث ويلزم منه أن يكون أمر ونهى وخبر واستخبار ولا مأمور و لا منهى
ولا مستخبرا عنه وذلك كله ممتنع وإن كان حادثا لزم أن يكون الرب تعالى
محلا للحوادث وهو محال
وأيضا فإن الامة من السلف والخلف مجمعة على
كون القرآن معجزة الرسول والبرهان القاطع على صدقه وذلك يجب أن يكون من
الأفعال الخارقة للعادات المقارنه لتحدى الانبياء بالرسالات فإنه أن كان
قديما ازليا لم يكن ذلك مختصا ببعض المخلوقين دون البعض إذ القديم لا
اختصاص له ولو جاز أن يجعل بعض الصفات القديمة معجزا لجاز ذلك على باقى
الصفات كالعلم والقدرة والإرادة إذ الفرق تحكم لا حاصل له
ومما يدل
على أنه فعل الله تعإلى ما ورد به التنزيل من قوله ما يأتيهم من ذكر من
ربهم محدث وقوله وكان أمر الله مفعولا وقوله إنا جعلناه قرءانا عربيا إلى
غير ذلك من الآيات
وأيضا فإن الأمة من السلف مجمعة على أن القرآن
كلام الله وهو منتظم من الحروف والأصوات ومؤلف ومجموع من سور وآيات ومن
ذلك سمى قرآنا أخذ من قول العرب قرأت الناقة لبنها في ضرعنا أي جمعته ومنه
قوله إن علينا جمعه وقرآنه
ولولا ذلك لما تصور أن يسمعه موسى وهو
لا محالة قد سمعه وهو مع ذلك مقروء بألسنتنا محفوظ في صدورنا مسطور في
مصاحفنا ملموس بأيدينا مسموع بآذاننا منظور بأعيننا ولذلك وجب احترام
المصحف وتبجيله حتى لا يجوز للمحدث لمسه ولا القربان إليه ولا يجوز الجنب
تلاوته وقد وردت الظواهر من الكتاب والسنة تدل على كونه مسموعا وملموسا
وأنه بحرف وصوت فمن ذلك قوله سبحانه وان احد من المشركين استجارك فأجره
حتى يسمع كلام الله وقوله لا يمسه إلا المطهرون وقول النبي عليه السلام لا
تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فتتناوله أيديهم وقوله إذا تكلم الله
بالوحى سمع صوته كجر السلسلة على الصفا وقوله عليه السلام من قرأ القرآن
وأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات إلى غير ذلك من السمعيات
والجواب
أما إنكار صدق المقدمة الكبرى فقد اوضحنا بطلانه وأما قولهم إنه يستحيل أن
يكون من جنس كلام البشر وإلا كان مشاركا له في العرضية والإمكان
فقد سبق الجواب عنه بما فيه كفاية تغنى عن إعادته وليس مرادنا من
إطلاق
لفظ الكلام غير المعنى القائم بالنفس وهو ما يجده الإنسان من نفسه عند
قوله لعبده ايتنى بطعام أو اسقنى بماء وكذا في سائر اقسام الكلام وهذه
المعانى هى التي يدل عليها بالعبارات وينبه عليها بالإشارات وإنكار تسميته
أو كونه كلاما مما لا يستقيم نظرا إلى الإطلاق الوضعى فإنه يصح أن يقال في
نفسى كلام وفي نفس فلان كلام ومنه قوله تعالى ويقولون في انفسهم ومنه قول
الشاعر ... إن الكلام لفى الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا
...
وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس
ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف
وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية وإطلاقات لفظية ولا حرج منها
بعد فهم المعنى
ثم لا سبيل إلى تفسير ذلك المعنى بالإرادة ولنفرض
الكلام في الأمر فإنها اما أ أن تكون الإرادة للامتثال أو لاحداث الصيغة
أو لجعلها دالة على الأمر على ما هو مذهبهم لا سبيل إلى القول بالأول فإنه
قد يؤمر بما ليس بمراد أن يمتثل وذلك كما في تكليف أبى جهل بالإيمان مع
عدم إرادة وقوعه منه بل كما في حالة السيد المتوعد من جهة السلطان على ضرب
عبده إذا اعتذر إليه بأنه يخالف امره وامره بين يدى السلطان طالبا بسط
عذره وهربا من عذاب السلطان له فإنا نعلم أنه لا يريد الامتثال من العبد
لما يلزمه من المحذور المتوقع
من السلطان ومع ذلك فإنه في نظر
أهل العرف والوضع آمر ويعد العبد بالمتثال مطيعا وبالإعراض عاصيا وبهذا
يندفع قول القائل إنه متوهم بالأمر وليس بأمر
ثم إن من الاحكام
التكليفية ما هو مأمور به بالإجماع من المعترفين بالتكاليف وذلك كالصلاة
والحج ونحوهما من العبادات وقد لا يكون مرادا لكونه غير واقع ولو كان
مرادا فالإرادة عبارة عن معنى يوجب تخصيص الحادث بزمان حدوثه فلو كان
المعنى الذي يوجب تخصيصه بزمان ما متحققا لما تصور ان لا يوجد مطلقا ولا
يمكن أن يقال بكونه غير مأمور لعدم تعلق الإرادة به إذ الأمة مجمعة على
وجوب نية الفرضية في أول الصلاة مع جواز الاخترام في وسطها ولو لم يكن
مأمورا بها وإلا لكان القصد الجازم إلى الفرضية من العالم بنفيها والمتشكك
في وقوعها محالا بل ومن عزم في اول الوقت على فعل الصلاة او غيرها مما فرض
من العبادات فالأمة أيضا مجمعة على أنه متقرب إلى الله تعالى ولو لم يكن
مأمورا وإلا لكان التقرب به إلى الله تعالى محالا
ومما يدل عليه ما
اشتهر من قصة إبراهيم من أمره بذبح ولده مع عدم تعلق الإرادة بوقوعه وما
قيل من أن ذلك كان مناما لا أمرا وأن تعلق الأمر لم يكن إلا بالعزم على
الذبح او الاتكاء وإمرار السكين او أن الذبح مما وقع واندمل الجرح فمندفع
إذ أكثر الوحى إلى الأنبياء إنما كان مناما ولو لم يكن ذلك بطريق الوحى
وإلا كان إقدام النبى على فعل محرم مما لا أصل له وذلك محال وحمل الامر
على غير الذبح من العزم او الاتكاء وإمرار السكين باطل وإلا لما صح تسميته
بلاء إذ لا بلاء فيه وتسمية الذبح بلاء لضرورة وقوع المأمور به وبه يندفع
القول بتحقق وقوع الذبح أيضا
كيف وأن تفسير الأمر بالإرادة مع
التسليم بكون البارى آمرا بأفعالنا مما يستحيل على أصل المعتزلى لضرورة
كونها مخلوقة لنا عنده وتعلق الإرادة بفعل الغير تمن وشهوة لا أنها إرادة
حقيقية وذلك على الله ممتنع فقد بان أن مدلول صيغة الأمر ليس هو نفس إرادة
الإمتثال وكذا يمكن إيضاح سائر أقسام الكلام
ولا جائز أن تكون
الإرادة لإحداث الصيغة فإنه ليس مدلولها ثم إن مدلولات أقسام الكلام
مختلفة ولا اختلاف في إرادة إحداث الصيغة من حيث هو كذلك
ولا جائز
أن تكون الإرادة لجعل الصيغة دالة على الأمر فإنه تصريح بأن الإرادة وراء
الأمر الذي هو مدلول قوله أمرتك وأنت مأمور ثم إن الألفاظ إنما هي دلائل
وتراجم عن اشياء وكل ذى عقل سليم يقضى بأن قول القائل امرتك ونهيتك ليس
ترجمة عن إرادة جعلها دالة على شئ مخصص
وعند هذا فلا بد من العود
إلى نفس مدلولها فإن كان نفس الإرادة فقد أبطلناه وإن كان غيرها فهو
المقصود كيف وأن الأنسان يجد من نفسه بقاء ما دلت عليه لفظة أمرتك من
الطلب والاقتضاء وإن عدمت اللفظة والإرادة جعلها دالة على شئ ما فقد امتنع
بهذا تفسيره بالإرادة
ولا سبيل إلى تفسيره إذ بالقدرة عبارة عن معنى
يتأتى به الإيجاد بالنسبة إلى كل ممكن والأمر والنهى لا يتعلق بكل ممكن
فإذا القدرة أعم من الأمر والنهى من وجه
والأمر عند القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق أعم من القدرة
من جهة أخرى وهو تعلقه بالممكن وغير الممكن
ولا سبيل الى تفسيره بالعلم إذ العلم أعم من الأمر من حيث إنه قد يتعلق
بما لم يتعلق به الأمر وبما يتعلق به الأمر وكيف تكون حقيقة الأعم هي
حقيقة الأخص كيف وإن كل انسان منصف يجد من نفسه لما يتلفظ به من العبارت
الدالة مدلولات وراء كل ما يقدر من العلوم فإذا قدر لاح الحق واستبان وظهر
أنه لا بد من معنى زائد على ما ذكروه هو مدلول العبارات والإشارات الحادثة
وإن كان في نفسه قديما وذلك المعنى هو الذي يجده الإنسان من نفسه عند
الإخبار عن أمور رآها أو سمع بها و عند قوله لغيره إفعل أو لا تفعل وتوعده
له ووعده إياه إلى غير ذلك وهو الذي يعنى بالكلام القائم بالنفس ولولاه
لقد كان يعد المتلكم بهذه العبارات مجنونا ومعتوها
وليس ذلك أيضا هو
ما سموه احاديث النفس التى هى تقديرات العبارات اللسانية وهو تحدث النفس
باللغات المختلفة كالعربية والعجمية ونحوها فإن هذه الامور لا يتصور
وجودها مع عدم العبارات اللسانية كما في حق الأبكم وتلك المعانى التى
عبرنا عنها بالكلام النفسانى تكون لديه حاضرة عتيدة وذلك كما في الطلب
والاقتضاء ونحوه وإن كان في نفسه أبكم لا تسوغ له عبارة ما حتى لو قررنا
وجود العبارات في حقه لقد كانت مطابقة لما في نفسه كما كانت مطابقة لما في
نفس غير الأبكم ثم إن هذه العبارات والتقديرات غير حقيقية أي ليست أمورا
عقلية
بل اصطلاحية مختلفة باختلاف الأعصار والأمم ولهذا لو وقع
التواضع من أهل الاصطلاح على أن يكون التفاهم بنقرات وزمرات لقد كان ذلك
جائزا ومدلولات هذه العبارات والتقديرات حقيقى لا يختلف باختلاف الأعصار
ولا باختلاف الاصطلاحات بل المدلول واحد وإن تغيرت تلك الدلالات وتلك
المدلولات هي التي يعبر عنها بالنطق النفسانى والكلام الحقيقى وما سواه
فليس بحقيقى
هذا كله ان قلنا إنه من جنس كلام البشر وإن نزلنا الكلام على أنه غير
مجانس له فقد سبق في تحقيقه ما يغنى عن إعادته
وأما ما أشاروا إليه من معنى الطاعة وتحقيق الرسالة فتمويه لا حاصل له
والا للزم أن يكون كل تسخير بفعل شئ ما امرا وتركه نهيا وأن يكون الانقياد
إلى ذلك التسخير طاعة كان ذلك في نفسه عبادة او معصية ولا يخفى ما في طى
ذلك من المحال فإنه ليس كل ما يسخر به مأمورا ولا كل ما انقاد العبد إلى
فعله يكون طاعة على ما لا يخفى وإذا كان الامر على هذه المثابة لم يصح
معنى التبليغ والرسالة عن الله اللهم إلا أن يكون له أمر نهى على ما
حققناه والمنهاج الذي أوضحناه
وأما الانفصال عن قول المعتزلة إن
المتكلم من فعل الكلام فهو ان الواحد منا لو تكلم بكلام مفيد فهو كلامه لا
محالة ولذلك يقال تكلم وهو متكلم وإذ ذاك فما جائز أن تكون جهة نسبته إليه
هو كونه فاعلا وإلا لما كان متكلما من خلق الكلام فيه اضطرارا وذلك كما في
حق المبرسم وكما في تسبيح الحصى وكلام الذراع المسموم ونحوه
بل
ويلزم على سياقه لمن اعترف منهم بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى
كالنجارية أن يكون البارى تعالى هو المتكلم بكلامنا لا نحن وذلك جحد
للضرورة ومباهتة المعقول وهو غير مقبول
ثم لو كان كذلك لوجب أن يكون
البارى تعالى مصونا لكونه فاعلا للصوت إذ الكلام على ما هو معتمد الخصم
مركب من الحرف والأصوات والصوت اعم من الكلام ولهذا صح عنده أن يقال إن كل
كلام صوت وليس كل صوت كلاما ومن ضرورة فعل الأخص فعل ما يندرج في معناه من
الأعم ويلزم أيضا أن يكون متحركا بما يفعله من الحركات ويسمى بكل ما ينسب
إليه من التكوينات والقائل بذلك منسلخ عن ربقة العقول وليس له فيما يعتمده
محصول كيف وأن الصفة الحادثه لها نسبة إلى الفاعل ونسبة إلى المحل فنسبتها
إلى الفاعل بأنه محدثها ونسبتها إلى المحل بأنها فيه وهما لا محالة معنيان
مختلفان وما نسب إلى الشئ بأنه فيه يقال بأنه موصوف به لا محالة حتى أن من
قامت به حركة يقال إنه متحرك وأن لم يخطر بالذهن كونه فاعلا أم لا بل
ونحكم عليه بذلك مع القطع بكونه غير فاعل لما قام به وذلك مؤكد كما في
حالة المرتعش ونحوه وعند ذلك فكيف يصح ان يقال إن ما نسبة الفعل اليه
بالإحداث يكون موصوفا به وكيف يؤثر الشيئان المختلفان في حكم واحد من كل
جهة ثم إن ما ذكرناه من أن قيام الصفة بالمحل يوجب اتصاف محله به يظهر
فساد ما ذكروه في رسم المتكلم بأنه من فعل الكلام حيث أنه لم يكن شاملا
لجميع مجارى المحدود والحد والرسم يجب أن يكون شاملا مطردا وإلا كان
المحدود أعم من الحد وهو محال
وأيضا فانه لو كان المتكلم من فعل
الكلام لوجب أن يكون المريد والقادر والعالم من فعل الإرادة والقدرة
والعلم وليس كذلك بالاجماع ولو طالبهم مطالب بجهة الفرق لم يجدوا إلى ذلك
سبيلا
ثم انه وإن تسومح في أن حقيقة مدلول اسم المتكلم بالنظر إلى
الوضع من فعل الكلام فغير مفيد بعد التسليم لما أوضحناه والموافقة لما
قررناه من أن المعنى بكونه متكلما قيام صفة نفسية به هي غير العلم والقدرة
و الإرادة و هي مدلول العبارات والمعنى بالإشارات كيف وإن ذلك مما يجب
تسليمه على موجب أصولهم فإنهم قالوا إن الكلام مركب من حروف منتظمة وأصوات
مقطعة تتعاقب وتتجدد منها تكون الكلمة ومن تركب الكلمات الكلام ومحلها
الذي تقوم به انما هو اللسان والمعانى المفهومة منها محلها إنما هو القلب
والجنان وإن من وجدت منه الأصوات والحروف بدون أن يكون لها عنده معنى في
فهمه كان معتوها مجنونا وإن سمى ما يجرى على لسانه كلاما فليس إلا بطريق
التجوز والاستعارة وعند ذلك فلو خلق الله تعالى كلاما مرتبا من حروف
منظومة وأصوات مقطعة لم يخل إما أن يكون لها مدلول عنده أو ليس لها مدلول
عنده لا جائز أن يقال بأنه لا مدلول لها وإلا كان ذلك جنونا وسفها وإن كان
لها مدلولا فيجب أن يكون غير العلم والقدرة و الإرادة لما أوضحناه وذلك هو
المعنى بكلام النفس
ثم نقول إذا قلتم إن الكلام فعل من أفعاله وإن
معنى كونه متكلما أنه فاعل الكلام فما طريقكم في إثبات هذه الصفة الفعلية
وما دليلكم فيها فإن قالوا دليل وقوعها كونها مقدورة له تعالى فيلزم أن
يكون كل مقدور واقعا وأن لا يتأخر مقدور ما عن وجود القدرة ولا يخفى ما في
طى ذلك من المحالات
وإن قالوا طريقنا في ذلك ليس إلا قول الأنبياء الذين دلت المعجزات على
صدقهم وقد قالوا إن الله تعالى متكلم بأمر ونهى وغيره
قلنا فلو لم يبعث الله رسولا فعندكم أنه يجب على العاقل معرفة الله تعالى
معرفة تتعلق بالذات والصفات فكيف يعرف كونه متكلما وذلك لا يعرف إلا
بالرسول ولا رسول
وهذا مما يلزمكم فيه المناقضة في أحد أمرين إما
في القول بإيجاب المعرفة بالعقل وإما في القول بأن المعرفة مناطة بالرسول
كيف وأن الرسول على الحقيقة ليس إلا المبلغ لكلام الغير كما حققناه سالفا
فلو لم يكن للبارى تعالى كلام غير كلام الرسول هو مدلول كلام الرسول وكلام
الرسول عبارة عنه لم يكن بذلك رسولا كما تقرر
وهذه المحالات كلها
إنما لزمت من القول بأن المتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام فقد
بطل ما تخيلوه وانقطع دابر ما توهموه وظهر كون البارى متكلما بكلام قائم
بذاته مختصا به كاختصاصه بباقى صفاته
ويلزم من ذلك أن يكون قديما أزليا وإلا كان البارى تعالى محلا للحوادث وقد
أبطلناه
وما قيل من أنه يلزم منه الكذب فيما يتضمنه من الأخبار فحاصله يرجع إلى
محض التشنيع ومجرد التهول وعند التحقيق تظهر مجانبته للذوق والتحصيل ولئن
سلكنا ما ذكره بعض الأصحاب من ان الكلام قضية واحدة ولا يتصف بكونه أمرا
ونهيا وخبرا واستخبار إلا عند وجود المخاطب واستكماله شرائط الخطاب زال
الشغب واندفع الإشكال ولئن توسعنا إلى ما سلكه الإمام ابو الحسن الأشعرى
رحمه الله من أنه متصف فيما لم يزل بكونه امرا ونهيا وخبرا إلى غير ذلك
فغير بعيد أن يكون في نفسه معنى واحدا
والاختلاف فيه إنما يرجع
إلى التعبيرات عنه بسبب تعلقه بالمعلومات فإن كان المعلوم محكوما بفعله
عبر عنه بالأمر وإن كان بالترك عبر عنه بالنهى وأما إن كان له نسبة إلى
حالة ما بأن كان وجد بعد العدم أو عدم بعد الوجود او غير ذلك عبر عنه
بالخبر وعلى هذا النحو يكون انقسام الكلام القائم بالنفس فهو واحد وان
كانت التعبيرات عنه مختلفة بسبب اختلاف الاعتبارات
ومن فهم هذا
التحقيق اندفع عنه الإشكال وزال عنه الخيال فإنه غير بعيد أن يقوم بذات
الله تعالى خبر عن إرسال نوح مثلا ويكون التعبير عنه قبل الإرسال إنا
نرسله وبعد الإرسال إنا أرسلنا نوحا فالمعبر عنه يكون واحدا في نفسه على
ممر الدهور وإن اختلف المعبر به وسببه اختلاف الأحوال والأزمنة وذلك لا
يفضى إلى الكذب بالنسبة إلى المعنى المعبر عنه وهو القائم بالنفس أوليا
بالنسبة إلى المعبر به أيضا فإن العرب قد تعبر بلفظ الماضى عن المستقبل
إذا لم يكن بد من وجوده حيث يعدونه بأنه وجد وذلك محض تجوز واستعارة ولا
بعد فيه
وكذلك أيضا يجوز أن يقوم بذاته طلب خلع النعل من موسى على
جبل الطور واقتضاؤه منه على تقدير وجوده ويكون المعبر عنه قبل الوجود
بصيغة إنا سنأمر وعند الوجود بصيغة اخلع الدالة على الطلب هو الاقتضاء
القديم الأزلى ولهذا لو قدر الواحد منا في نفسه اقتضاء فعل من شخص معدوم
واستمر ذلك الاقتضاء إلى حين وجود المقتضى منه فإنه إذا علم به إما بواسطة
أو بغير واسطة وكان الطالب يجب الانقياد له والإذغان لديه كان ذلك
الاقتضاء بعينه امرا له وموجبا لانقياده وطاعته من غير استئناف طلب آخر
واقتضاء آخر فعلى هذا النحو هو أمر الله تعالى للمعدوم وتعلقه به واشتراط
فهم المأمور إنما يكون عند تعلق الخطاب به في حال وجوده لا غير ومن فهم
كلام النفس
ورفع عن وهمه الأزمان المتعاقبة والاحوال المختلفة
وحقق ما قررناه في مسألتى العلم و الإرادة وجد الأمر ما ذكرناه ولم يخف
عليه ما مهدناه
ولقد استروح بعض الأصحاب في تقرير هذا الكلام إلى
طريق أورده في معرض المناقضة والإلزام فقال كيف يصح استبعاد تعلق الأمر
بمأمور معدوم وعندكم أنه لا يتناول المأمور به إلا قبل حدوثه ومهما وجد
خرج عن أن يكون مأمورا به وهو أحد متعلقى الأمر فإذا لم يبعد تعلق الأمر
بالفعل المعدوم لم يبعد تعلقه بالفاعل المعدوم وأيضا فإن الأمة مجمعة على
أننا في وقتنا هذا مأمورون وعندكم لا أمر إذ الامر قد تقضى ومضى فإذا لم
يبعد وجود مأمور ولا أمر فلا يبعد وجود أمر بلا مأمور ولو لزم من وجود
الأمر وجود المأمور للزم من وجود القدرة وجود المقدور وذلك يفضى إلى قدم
المقدور إذ قد سلم قدم القدرة وذلك محال على كلا المذهبين
وهذا مما
فيه نظر وذلك أن الأمر والنهى بالنسبة إلى المأمور والمنهى عند الخصم
تكليف والتكليف يستدعى مكلفا به والمكلف به يجب أن يكون معلوما مفهوما
ليصح قصده من أجل الإتيان به والانتهاء عنه إذ هو مقصود التكليف فإذا
الفهم شرط في التكليف ولهنا خرج من لا فهم له عن أن يكون داخلا في دائرة
التكليف كما في الجمادات وأنواع الحيوانات والصبيان والمجانين ونحو ذلك
لعدم شرط التكليف في حقهم وإذ ذاك فلا يلزم من تعلق الأمر بالمأمور به مع
عدم الفهم تعلقه بالمأمور مع عدم اشتراط الفهم فإن تعلقه بالمأمور به ليس
تعلق تكليف ولا كذلك تعلقه بالمأمور
وأما القول بأنه إذا جاز
وجود مأمور ولا أمر جاز وجود أمر لا مأمور فهذا إنما يتحقق أن لو صح وجود
مأمور ولا أمر والخصم ربما لا يسلم ذلك بل له أن يقول كل مأمور فلا بد له
من امر يتعلق به لكن ذلك الأمر قد يكون وجوده تقديرا بالنسة إليه كما يقدر
وجود العقد في البيع والنكاح بالنسبة إلى تحقيق ثمراته وأحكامه أما أن
يكون مأمور من غير أمر فلا وإذ ذاك فلا يلزم من تقدير وجود الأمر عند وجود
المأمور وتعلقه به تقدير وجود المأمور لأن يتعلق به الأمر فإنه غير مفيد
إلا مع وجود شرطه وهو العلم والفهم وذلك متعذر في حق المعدوم وعلى هذا
يخرج الإلزام بالقدرة إذ القدرة ليست عبارة إلا عن معنى يتأتى به الإيجاد
فيما هو ممكن أن يوجد وذلك متحقق بدون وجود المقدور فلئن رجع في تقديرة
جواز تعلق الأمر بالمعدوم ومن لا فهم له إلى ما أسلفناه كان ذلك كافيا
ووجب الاعتناء به
وأما ما قيل من أن القرآن معجزة الرسول فيمتنع أن
يكون قديما فتهويل لا حاصل له فإنا مجمعون على أن القرآن الحقيقى ليس
بمعجزة الرسول وإنما الاختلاف في أمر وراءه وهو أن ذلك القرآن الحقيقى
ماذا هو فنحن نقول إنه المعنى القائم بالنفس والخصم يقول إنه حروف وأصوات
أوجدها الله تعالى وعند وجودها انعدمت وانقضت وأن ما أتى به الرسول وما
نتلوه نحن ليس هو ذلك وإنما هو مثال له على نحو قراءتنا لشعر المتنبى
وامرئ القيس فإنه ليس ما يجرى على ألسنتنا هو كلام امرئ القيس وإنما هو
مثله فمن الوجه الذي لزمنا القول بمخالفة الإجماع هو أيضا لازم لهم
ولأجل ذلك فر الجبائي إلى مذهب خرق به حجاب العقل وارتكب فيه جحد الضرورات
والتزم به القول بالمحالات فقال إن الله تعالى يخلق كلامه عند قراءة
كل قارئ وكتابة كل كاتب وزعم أن الكلام إنما هو حروف منظومة
تقارن الأصوات
المتقطعة وليست الحروف نفس الأصوات المتقطعة ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة
المعقول فإن عاقلا ما لا يمارى في أن ما نسمعه من الأفواه إنما هو أصوات
متقطعة منسقة منتظمة نوعا من الانتظام تخرج من مخارج مخصوصة وأيضا فإنه لا
يعقل معها مقارنة غيرها غيرها أصلا على ان لا تنازع في أن ما جاء به
الرسول من الحروف المنتظمة والأصوات المقطعة معجزة له وأنه يسمى قرآنا
وكلاما وأن ذلك ليس بقديم وإنما النزاع في مدلول تلك العبارات هل هو صفة
قديمة أزلية أم لا
وعلى التحقيق فالخبط إنما نشأ لأهل الضلال ههنا
من جهة اشتراك لفظ القرآن فإنه قد يطلق على المقروء وقد يطلق على القراءة
التي هي حروف وأصوات ودلالات وعبارات ومنه قول النبي صلى الله عليه و سلم
ما أذن الله لشئ إذنه لنبى حسن الترنم بالقرآن أي القراءة ومنه قول الشاعر
... ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقراءنا ...
معناه قراءة وذلك كما قد تطلق العرب اسم الكلام على المعنى تارة وعلى
العبارات أخرى ولذلك يقولون كلام صحيح حسن إذا كان مستقيما وإن كانت
العبارة غير مستقيمة بأن كانت ركيكة أو ملحونه أو مخبطة وقد يطلقونه على
العبارة عند كونها معبرة صحيحة وإن كان المعنى في نفسه فاسدا لا حاصل له
فلما وقع الاشتراك في الاسم ارتفع التوارد بالنفى والإثبات على محز واحد
فإن ما أثبتوه معجزة لا نثبت له القدم وما أثبتنا له القدم لا يثبتونه
معجزة
وما أوردوه من الظواهر في معرض إثبات الحدث والأولية فظنية
غير يقينية كيف وإن قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يحتمل أن يكون
معناه الوعظ والتذكير الخارج عن القرآن وهو الأقرب فإن القرآن لم يحدث
عندهم لعبا وضحكا بل إفحاما وإشداها ثم القول بموجب الآية متجه لا محالة
فإنها دلت على الضحك واللعب عند ورود الذكر الحادث وليس فيها دلالة على
حدث كل ما يرد من الأذكار فلا يلزم أن يكون القرآن حادثا ثم إن المراد
إنما هو العبارات والدلالات دون المدلولات كما حققناه
وأما قوله
وكان امر الله مفعولا فيصح أن يقال المراد به فعله من الثواب والعقاب
ونحوه فإن الأمر قد يطلق بإزاء الفعل كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة
أي فعلنا وقوله وما أمر فرعون يعنى فعله
والمراد بقوله إنا جعلناه
قرآنا عربيا أي سميناه فإن الجعل قد يطلق بمعنى التسمية ومنه قوله تعالى
الذين جعلوا القرآن عضين أي سموه كذبا وقوله وجعلوا الملائكة الذين هم
عباد الرحمن إناثا سموهم بذلك كيف وأنه يحتمل أنه اراد به القرآن بمعنى
القراءة كما بيناه وذلك لا يقدح في المقصود ثم إن هذه الآيات معارضة
بمثلها وهو قوله تعالى ألا له الخلق والأمر فقد أثبت له خلقا وأمرا فلو
كان الأمر مخلوقا لكان معنى الكلام ألا له الخلق والخلق وأيضا قوله إنما
قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له
كن فيكون فلو كان الأمر مخلوقا
لاستدعى ذلك سابقة أمر آخر وذلك يفضى إلى التسلسل وهو محال وبما قررناه
يندفع قولهم أيضا إن الأمة من السلف مجمعة على ان القرآن مؤلف من الحروف
والأصوات فإن الإجماع إنما انعقد على ذلك بمعنى القراءة لا بمعنى المقروء
وإليه الإشارة بقوله إن علينا جمعه وقرآنه
وقولهم لو لم يكن كذلك
لما سمعه موسى قلنا الدليل إنما لزم المعطل ههنا من حيث إنه لم يفهم معنى
السماع وإنه بأى اعتبار يسمى سماعا وعند تحقيقه يندفع الإشكال فنقول
السماع قد يطلق ويراد به الإدراك كما في الإدراك بحاسة الأذن وقد يطلق
ويراد به الانقياد والطاعة وقد يطلق بمعنى الفهم والإحاطة ومنه يقال سمعت
فلانا وإن كان ذلك مبلغا على لسان غيره ولا يكون المراد به غير الفهم لما
هو قائم بنفسه والذي هو مدلول عبارة ذلك المبلغ وإذا عرف ذلك فمن الجائز
أن يكون قد سمع موسى كلام الله تعالى القديم بمعنى أنه خلق له فهمه
والإحاطة به إما بواسطة أو بغير واسطة والسماع بهذا الاعتبار لا يستدعى
صوتا ولا حرفا
وما يطلق عليه من الحروف والأصوات أنه كلام الله
تعالى فليس معناه إلا أنه دال على ما في نفسه وذلك كما يقال نادى الأمير
في البلد وإن كان المنادى غيره ويقال لمن أنشد شعر الحطيئة إنه متكلم
بكلام الحطيئة وشعره ومن ذلك سمى الوحى كلاما لله تعالى حتى يقال تكلم
الله بالوحى والوحى كلامه ولا ننكر أن القرآن القديم مكتوب ومحفوظ ومسموع
ومتلو لكن ليس معنى كونه مكتوبا او محفوظا أنه حال في المصاحف أو الصدور
بل معناه أنه قد حصل فيها ما هو دال عليه وهو مفهوم منه ومعلوم
وليس
معنى كونه منزلا أنه منتقل من مكان إلى مكان فإن ذلك غير متصور على كلا
المذهبين بل معناه أن ما فهمه جبريل من كلام الله تعالى فوق سبع سموات عند
سدرة المنتهى ينزل بتفهيمه للأنبياء إلى بسيط الغبراء وكذلك ليس معنى كونه
مسموعا إلا ما ذكرناه فيما مضى ومن حقق ما مهدناه واحاط بما قررناه هان
عليه التفضى عن كل ما أوردوه من الظاهر الظنية واعتمدوه من الآثار النبوية
ولعل معتمد المعطلة في إثبات الحروف والأصوات هو ما قاد الحشوية لعدم
فهمهم كلام النفس إلى إثباتها صفة للذات فإنه لما لم يسعهم القول بالتعطيل
ولم يقدروا على التأويل لهذا التهويل جمعوا بين الطريقتين وانتحلوا مذهبا
ثالثا بين الذهبين ولم يعلموا ما في طى ذلك من السفاهة وفي ضمنه من
الفهاهة لما فيه من الهرب إلى التجسيم خوف الوقوع في التعطيل إذ الحروف
والأصوات إنما تتصور بمخارج وأدوات وتزاحم أجرام واصطكاكات وذلك في حق
البارى محال كما سلف
فانظر إلى هاتين الطائفتين كيف التزم بعضهم
التعطيل خوف التجسيم والتزم بعضهم بعضهم التجسيم خوف التعطيل ولسان الحال
ينشد على لسان الفريقين ويعبر عن حال الجمعين وقالت اليهود ليست النصارى
على شئ وقالت النصارى ليست اليهود على شئ
نعم لو قيل إن كلامه بحروف
وأصوات لا كحروفنا وأصواتنا كما أن ذاته وصفاته ليست كذاتنا وصفاتنا كما
قال بعض السلف فالحق أن ذلك غير مستبعد عقلا لكنه مما لم يدل الدليل
القاطع على إثباته من جهة المعقول أو من جهة المنقول فالقول به تحكم غير
مقبول
وعند ظهور الحقائق وانكشاف الدقائق فلا مبالاة بتلويق
المتحذلق المتعمق الذي لا تحصيل لديه ولا معول في تحقيق الحقائق عليه إذ
هو في حيز الجهال وداخل في زمرة أهل الضلال
وإذا ثبتت الصفة
الكلامية فهي متحدة لا كثرة فيها وما أشرنا إليه في إثبات وحدة الإرادة
والعلم من المزيف والمختار والاعتراض والانفصال فهو بعينه يتجه ههنا لكن
ربما زاد الخصم ههنا تشكيكا وخيالا وهو قوله ما ذكرتموه وإن دل على عدم
لزوم صفات خارجة فالقول بإثبات أصل الكلام مفض إليها أيضا وذلك أن من
ضرورة وجود حقيقة الكلام أن يكون أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا
ونحوه من
أقسام الكلام وإلا فمع قطع النظر عن هذه الأقسام لا سبيل إلى تعلق وجود
الكلام وإذا كان الأمر على هذه المثابة فلا محالة أن هذه الأقسام مختلفة
الصفات متباينة في الخواص والمميزات وعند هذا فإما أن تكون هذه الخواص
المتمايزة والصفات المختلفة داخلة في حقيقة الكلام أو خارجة عنه فإن كانت
داخلة فيه فهو محال وإلا كانت الحقيقة الواحدة لها ذاتيات مختلفة متنافرة
إذ خاصة الأمر يتعذر القول بمجامعتها لخاصة النهى وكذا في سائر خواص
أقسامه وإن كانت خارجة عن حقيقة الكلام فقد لزم القول بثبوت صفات زائدة
على ما دل عليه الدليل ولزمكم المحذور
ثم إن هذه الصفات الزائدة لا
جائز أن تكون لحقيقة واحدة لا تعدد فيها على نحو ثبوت الضحك والبكاء
للإنسان لكونها متنافرة متعاندة على ما سلف فبقى أن تكون معتددة لا محالة
وسواء كان تعددها تعدد الأشخاص أو الأجناس فإن ذلك يوجب نقض ما ذكرتموه
وإبطال ما سلكتموه ولربما استندوا في بيان التعدد إلى ما أوردوه في نفى
الكلام عن الذات من الإجماعات والظواهر من السنن والآيات الدالة على كون
القرآن مؤلفا من حروف وأصوات وأنه مرتب من سور وآيات ومجموع من كلمات
والجواب أنا نقول تعدد أقسام الكلام واختلاف أسمائه من الأمر والنهى وغير
ذلك ليس هو له باعتبار تعدد في نفسه أو اختلاف صفات في ذاته أو لذاته
بل هو النظر إلى نفسه من حيث هو كلام واحد وذلك ليس له إلا
باعتبار إضافات
متعددة وتعلقات متكثرة لا توجب للمتعلق في ذاته صفة زائدة ولا تعددا كما
أسلفنا في الطرف الأول من التحقيق
وهو على نحو قول الفيلسوف في
المبدأ الأول حيث قضى بوحدته وإن تكثرت أسماؤه بسبب سلوب وإضافات وأمور لا
توجب صفات زائدة على الذات هذا كله إن سلكنا في التكثر مذهب الإمام أبى
الحسن الأشعرى وإلا إن سلكنا مذهب عبد الله ابن سعيد في أن الأمر والنهى
وغير ذلك لا يكون إلا عند تحقق المتعلقات وأن الكلام خارج عنها أو ما نقل
عن بعض الأصحاب من أنه إثبت لله تعالى من الكلام خمس كلمات هي خمس صفات
وهى الأمر والنهى والخبر والإستخبار والنداء فالإشكال يكون مندفعا
وعلى ما ذكرناه من التحقيق يتبين أن من قال من الأصحاب القائلين بنفى
التكثر إن الأوامر والنواهى وغيرها صفات خارجة عن الكلام ولم يرد به ما
أشرنا إليه فقد أخطأ
وأما ما اعتمدوه من الظواهر الظنية والأدلة السمعية فقد سبق وجه الانفصال
عنها فلا حاجة إلى التطويل وبإعادة
فإن قيل عاقل ما لا تمارى نفسه في انقسام الكلام إلى أمر ونهى وغيره وأن
ما انقسم إليه حقائق مختلفة وأمور متنافرة متمايزة وأنها من أخص أوصاف
الكلام لا أن الأختلاف راجع إلى نفس العبارات والاعتبارات الحارجة فإنا لو
قطعنا النظر عن
الاعتبارات الخارجة والمتعلقات ورفعناها وهما لم
يخرج عن كونه منقسما ومع هذا التحقيق كيف يسوغ القول بالاتحاد ثم ان ما
اخبر عنه من القصص الماضية والأمور السالفة مختلفة متمايزة فإن ما جرى لكل
نبى من الانبياء غير ما جرى لغيره من الانبياء وكذلك المأمورات والمنهيات
المكلف بها مختلفة متغايرة فكيف يكون نفس الخبر عما جرى لآدم وإبراهيم هو
نفس الخبر عما جرى لموسى او عيسى أم كيف يكون نفس الامر بالحج هو نفس
الأمر بالصلاة وأن ما توجه لزيد هو نفس ما توجه لعمرو وكيف هذا التداخل أم
كيف يجعل الخبر أو ما سمى خبرا هو عين الأمر أو ما سمى أمرا هو عين ما سمى
خبرا مع أن الأمر هو الطلب والاقتضاء والخبر لا يشتمل على شئ من ذلك وما
اشتمل عليه الخبر فالأمر أيضا غير مشتمل عليه فهل هذا إلا محض تحكم غير
معقول وما ليس بمعقول لا سبيل إلى إثباته فلم يبق إلا أنه أنواع متمايزة
الخواص مختلفة الذوات مشتركة في الجملة والكلام كالجنس لها
والتمثيل
بالمبدأ الأول مما لا إليه سبيل فإن اتحاد الذات مع اختلاف اسمائها
باعتبار أمور إضافية أو سلبية مما لا امتناع فيه أما إثبات صفات متضادة
وخواص متنافرة وأقسام متعددة لذات واحدة لا تعدد فيها ولا تغاير فمن أمحل
المحالات وأشنع المقالات ولا سبيل إليه
قلنا قد بينا فيما سلف أن
الكلام قضية واحدة ومعلوم واحد قائم بالنفس وأن اختلاف العبارات
والتعبيرات عنه إنما هو بسبب اختلاف المتعلقات والنسب والإضافات كما
حققناه فما يقع به التضاد أو الاختلاف أو التعدد فليس إلا في
المتعلقات والتعلقات لا في نفس المتعلق ولا أن ما وقع به
الاختلاف أو
التضاد بين الأمر والنهى وغيره من أخص صفات الكلام بل كل ذلك خارج عنه
وعلى هذا نقول لو قطع النظر عن المتعلقات الخارجة ورفعت عن الوهم فإنه لا
سبيل إلى القول بهذه العبارات والتعبيرات أصلا ولا يلزم من ذلك رفع فهم
الكلام وأن تزول حقيقته عن الوجود ايضا
وقولهم كيف يجوز أن يكون
المخبر عنه متعددا مختلفا والخبر عنه واحدا أم كيف يكون المأمور به مختلفا
والأمر به واحدا وكيف تكون حقيقة واحدة هى أمر ونهى وخبر مع أن هذه الامور
مختلفة
قلنا هل هذا إلا محض استبعاد وخروج عن سبيل الرشاد فإنه إذا
عرف أن اختلاف العبارات والتعبيرات قد يكون باعتبار اختلاف التعلقات
والنسب إلى الأمور الخارجة والإطلاقات لم يمتنع أن يكون المتعلق له حقيقة
واحدة ووجود واحد وله متعلقات مختلفة ويعبر عنه بسبب تعلقة بكل واحد منها
بعبارة مخصوصة ولقب مخصوص وإن كان هو في نفسه واحدا وذلك على نحو ما ذكره
الفيلسوف في المبذأ الأول وعلى نحو ما ينعكس على الأرض من الألوان
المختلفة من زجاجات مختلفة الألوان بسبب شروق الشمس عليها ومقابلتها لها
فإن التأثيرات مختلفة بسبب المتعلقات لا غير وإن كان المتعلق في نفسه
واحدا وقد يعبر عنها بسبب هذا التقلق واختلاف المتقلقات والتأثيرت بأسماء
مختلفة حتى يقال إنها مسودة ومصفرة وغير ذلك وإن كانت الشمس في نفسها
واحدة فكذلك ينبغى أن يفهم مثله في الكلام فإن اختلاف هذه التعبيرات عنه
ليس لتعدد في نفسه بل لتعدد المتعلقات واختلاف
الإضافات وذلك ليس محالا نعم لو عبر عنه بالنهى من جهة ما عبر
عنه بالأمر ومن جهة ما عبر عنه بالخبر أو بالعكس كان ذلك متناقضا
ومن حقق ما مهدناه زال عنه الخيال واندفع عنه الإشكال كيف وأن ما ذكروه من
أقسام الكلام وهى الخبر والاستخبار والأمر والنهى والوعد والوعيد أمكن أن
ترد إلى قسمين وهما الطلب والخبر فإن الوعيد والوعد داخلان في الخبر لكن
تعلق بأحدهما ثواب فسمى وعدا وتعلق بالآخر عقاب فسمى وعيدا وأما الأمر
والنهى فداخلان تحت الطلب والاقتضاء لكن إن تعلق بالفعل سمى امرا وإن تعلق
بالترك سمى نهيا وأما الاستخبار على الحقيقة فغير متصور في حق الله تعالى
بل حاصله يرجع إلى التقرير وهو نوع من الإخبار وذلك كما في قوله تعالى
ألست بربكم قالوا بلى وكما أمكن رد هذه الأقسام إلى قسمين أمكن ردها إلى
قسم واحد في حق الله تعالى حتى يكون على ما ذكرناه بأن يكون معنى واحدا
وقضية متحدة إن تعلق بما حكم بفعله أو تركه سمى طلبا وإن تعلق بغيره سمى
خبرا
فإذا المتعلقات متعددة والمتعلق في نفسه واحدا لا تعدد فيه
وهذا كله إنما هو في متصور البقاء والديمومة كما في كلام الله تعإلى وإلا
فالكلام في الشاهد إعنى كلام اللسان والنطق النفسانى ليس كذلك إذ هو من
قبيل الأعراض المتجددة والأغراض المتغيرة وذلك مما ينافى القول باتحاده
ونفى أعداده
فإن قيل إذا قلتم بأن الكلام في نفسه قضية واحدة وأن
اختلاف التعبيرات عنه إنما هو بسبب المتعلقات الخارجة فلم لا جوزتم أن
تكون الإرادة والعلم والقدرة
وباقى الصفات راجعة إلى معنى واحد
ويكون اختلاف التعبيرات عنه بسبب اختلاف متعلقاته لا بسبب اختلافه في ذاته
وذلك بأن يسمى إرادة عند تعلقه بالتخصيص في الزمان وقدرة عند تعلقه
بالتخصيص في الوجود وهكذا سائر الصفات وإن كان ذلك فلم لا يجوز أن يعود
ذلك كله إلى نفس الذات من غير احتياج إلى الصفات
قلنا تمويه هذا الإشكال والتهويل بهذا الخيال هو ما اوقع جماعة من الأصحاب
في دائرة الاضطراب وكبع حذاقهم عن تحقيق الجواب
والذي يقطع دابره ويكشف عن الحق سرائره أن يقال إذا ثبت القول بكونه محيطا
بالموجودات وعالما بها ومخصصا لها في وجودها وحدوثها وثبت له غير ذلك من
الكمالات المعبر عنها بالصفات فهو ما طلبناه وغاية ما رمناه وأما إثبات
كونها متغايرة الذوات متباينة الذاتيات أو أنها راجعة إلى معنى واحد هو
نفس الذات والتخصيص والاختلاف فيها إنما هو عائد إلى المتعلقات والتغاير
بالعرضيات الخارجيات كما ذهب إليه بعض الأصحاب فما لم أر في ما ذكروه
لإفحام الخصم كلاما مخلصا عن مغالطات ومصادرات وأقاويل منحرفات وما يظهر
مأخذ المعتقد من الجانبين فإنما ينتفع به الناظر مع نفسه لا بالنظر إلى
غيره
وأظهر ما قيل في بيان الاختلاف أن تأثير القدرة في الإيجاد وتأثير الإرادة
في التخصيص بالأحوال والأقات ومع اختلاف التأثيرات لا بد ممن
اختلاف
المؤثرات وإلا كان صدور أحد المختلفين من جهة ما صدر المخالف الآخر وهو
محال وهذا خلاف الكلام فإن تعلقه بمتعلقاته لا يوجب تأثيرا مختلفا وكذا كل
صفة على انفرادها
وهو غير سديد فإنه لو وجب القول بمخالفة القدرة
للإرادة لاختلاف التأثيرات فذلك يوجب الاختلاف في نفس الإرادة ونفس القدرة
وكل صفة من الصفات وإنما كان كذلك من جهة أن تأثيرات الإرادة متعددة فإن
تخصيص الحادث في الأمس غير تخصيصه في اليوم أو الغد وكذلك ما يخص بالقدرة
فإن إيجاد زيد ليس هو نفس إيجاد عمرو لا سيما إذا قلنا إن الوجود ليس
بزائد على الموجود وإذا كانت التأثيرات متغايرة فإما أن تتحد من كل وجه او
تختلف من كل وجه أو تتحد في وجه وتختلف في وجه اخر فإن اتحدت من كل وجه
فلا تعدد وقد فرضت متعددة فبقى أن تكون مختلفة إما من كل وجه أو من وجه
وعلى التقديرين فهى مختلفة فيجب أن يكون المؤثر لها مختلفا فإن لم يجب أن
يكون مختلفا فلا أقل من أن يكون معتددا
فإن قيل تاثير القدرة واحد
قي حقيقتة ومعناه واحد في ماهيته فإن الإيجاد من حيث هو إيجاد لا يختلف
وكذلك تخصيص الإرادة بالوقت واحد لا يختلف من حيث هو كذلك وما وقع به
الاختلاف في تأثيرات القدرة او الإرادة فليس اختلافا ذاتيا داخلا في
التأثير من حيث هو تأثير تلك الصفة المخصوصة وإنما هو عائد إلى أمور خارجة
عرضية وكذا في كل صفة على حدة وذلك مما يوجب الاختلاف في نفس التعلق أصلا
وهذا أيضا مما لا حاصل له فإنه إن صدر ممن لا يعترف بكون الوجود
زائدا على
الموجود كان بطلانه ظاهرا وإن كان ممن يعترف به فالذوات عنده إما أن تكون
متعلق القدرة مع كون الوجود والحدوث متعلقا لها أيضا أو أنها لا تعلق
للقدرة بها فإن كان الأول فقد لزمه اختلاف التأثيرات وإن كان الثانى لزم
أن تكون الذوات ثابتة في القدم ومتحققة في العدم وسيأتي إبطاله كيف وان
ذلك لو صح في القدرة والأرادة فهو مما لا يأتى في غيرهما من الصفات ولا
يتحقق في باقى الكمالات بالنسبة إلى مالها من المتعلقات
وإذا لاحت
الحقائق وظهرت الدقائق فلا التفات إلى شغب المشنع المتحذلق فإن ذلك مما لا
ينهض دليلا ولا يشفى غليلا وهو آخر ما أردناه من مسألة الكلام وهو
المستعان وعليه التكلان
الطرف الخامس
في اثبات الادراكاتمذهب أهل الحق أن البارى تعالى سميع بسمع بصير ببصر
وذهب الكعبى إلى أن معنى كونه سميعا بصيرا أنه لا آفة به عالم بالمسموعات والمبصرات لا غير
ومن المعتزلة من زاد عليه وقال معنى كونه سميعا بصيرا أنه مدرك للمسمسوعات والمبصرات والإدراك يزيد على العلم
وذهب الجبائى ومن تابعه إلى أن معنى كونه سميعا بصيرا أنه حى لا آفه به وقد استروح بعض الأصحاب في الاستدلال على أهل الضلال إلى مسلك ضعيف وهو أن قال البارى تعالى حى والحى إذا قبل معنى وله ضد ولا واسطة بينهما لم يخل عنه أو عن ضده ولا محالة أن كونه حيا مما يوجب قبوله للسمح والبصر فلو لم يتصف بالسمع والبصر لا تصف تضدها وذلك نقص في حق البارى تعإلى
قال
والدليل على أن الموجب لقبوله السمع والبصر كونه حيا ما نراه في الشاهد
فإن الموجب لقبوليه الإنسان وغيره من الحيوان للسمع والبصر كونه حيا إذ لو
قدر أن الموجب لذلك غير الحياة من الأوصاف لكان منتقضا وإذا كان الموجب
للقبول إنما هو الحياة فالبارى حي فيجب أن يكون متصفا بهما وإلا كان متصفا
بأضدادهما وذلك نقص في حق الله تعالى فيمتنع
ومن نظر فيما أسلفناه وأحاط بما مهدناه علم أن ذلك مما لا يقوى والذي
نزيده ههنا أنا نقول
حاصل الطريقة آيل إلى قياس التمثيل وهو الحكم على جزئى بما حكم به على
غيره لاشتراكهما في معنى عام لهما وهو إنما يستقيم أن لو لم يتبين أن
الحكم في الأصل الممثل به ثابت لمعنى لا أنه ثابت لنفسه أو بخلق الله له
في ذلك الامر الجزئى من غير افتقار إلى أمر خارج ثم لو ثبت أنه ثبت لمعنى
لكن لا بد من حصر جميع الأوصاف وذلك لا يتم إلا بالسبر وهو غير مفيد
لليقين بل حالصه انى بحثت فلم أطلع على غير المذكور وغاية فائدة البحث
الظن بانتفاء غير المعين لا العلم به
ثم وإن أفاد علما للساير فذلك
ليس بحجة على غيره إذ بحث زيد لا يؤثر علما في حق عمرو وإن أفاده ذلك ظنا
وليس هذا كما يقال إن من كان بين يديه قيل وليس بينه وبينه حائل وآلة
الإدراك لديه حاضرة سليمة فإنه يستحيل ألا يبصره فكذلك ههنا فإنه لو قدر
وصف آخر فإنه إما معقول أو محسوس وأي الأمرين قدر فأسباب مداركه عند
الناظر عتيدة فيستحيل ان لا يظفر به إذا طلبه
وهذا وإن كان مخيلا
لكنه مما لا يقوى فإنه لو كان الأمر على ما ذكره لما وقع لأحد في نظره خبط
ولا في فكره تناقض ولما وقع الخلاف بين العقلاء في وجود شئ ونفيه إذ
القواطع
لا تتوارد على شئ ونقيضه وكم من وقع له التناقض في نظره
حتى انه حكم بشئ بعد ما حكم بمقابله وكذلك كم من شئ اختلف العقلاء فيه ولم
يظفر ولا واحد منهم بمقصود او ظفر به واحد دون الباقين ولا كذلك ما ذكروه
من المثال فإن وقوع مثل ذلك فيه مما يستحيل بالنظر إلى حكم جرى العادة به
ثم ولو سلم الحصر فلابد وأن يتعرض لابطال تأثير كل واحد واحد على الخصوص
وابطال تأثيره في كل رتبة تحصل له من إضافته إلى غيره وذلك مما يعز ويشق
لا محالة وما وقعت الإشارة به في إبطال غير المستبقى فهو بعينه لازم في
المستبقى فإنه منتقض بباقى اعضاء الأنسان واعضاء غيره من الحيوان فإنها
حية مع انتقاء السمع والبصر وانتفاء أضدادها أيضا
ثم إنه وإن لم يكن
الحكم لغير ما عين من الأوصاف لكن من الجائز أن يكون ذلك باعتبار الشئ
الموصوف به ومهما لم يتبين أن الموصوف به في محل النزاع هو الموصوف به في
محل الوفاق لم يلزم الحكم وهذا كله لا محيص عنه فقد بان أن ما استروح إليه
غير يقينى وإن كنا لا ننكر كونه ظنيا فالمطلوب ليس إلا اليقين
ولربما استند بعض الأصحاب ههنا إلى السمعيات دون العقليات والمحصل يعلم أن
كل ما يتمحل من ذلك فغير خارج عن قبيل الظنيات والتخمنيات وذلك لا مدخل له
في اليقينيات وسيأتى إشباع القول في ذلك إن شاء الله تعالى
فإذا
السبيل في الدليل ههنا ليس إلا ما أشرنا إليه في مسألة الإرادة وقد عرفت
وجه تحقيقه وما يلزم عليه لكن ربما زاد الخصم ههنا تشكيكات وخيالات لابد
من الإشارة إليها والتنبيه على وجه الانفصال عنها
فمن ذلك قوله إن
ما ذكرتموه إنما يستقيم أن لو ثبت أن السمع والبصر إدراكان زائدان على نفس
العلم وإلا فلا نقص إدراك ولا قصور لكون البارى تعالى عالما
وبم
الإنكار على الكعبى حيث ذهب إلى ان السمع والبصر ليسا بزائدين على نفس
العلم لا شاهدا ولا غائبا بل المدرك المسموع والمبصر هو السامع المبصر
بعلمه لا بحاسته التى كان حصول هذا العلم بواسطتها وهى المعبر عنها بالسمع
والبصر كيف وأنه لو كان المدرك مدركا بإدراك زائد على العلم لجاز أن يكون
بين يدى الإنسان سليم البصر والسمع مرئيات وأصوات وهو لا يراها ولا يسمعها
لجواز أن لا يخلق له ادراكها والأمر بخلافه ثم لو سلم أن الإدراك ليس هو
نفس العلم فبم الانكار على الجبائى في قوله إن المدرك هو الحى الذى لا آفة
به ولا نقص وأنه لا معنى له إلا هذا السلب
ثم لو سلم أنه معنى
إيجابى وأمر إثباتى لكنه مما يمتنع ثبوته في حق البارى تعالى من حيث إنه
لا يخلو أن يكون قديما أو حادثا لا جائز أن يكون حادثا وإلا كان البارى
محلا للحوادث وهو ممتنع ولا جائز أن يكون قديما وإلا للزم أن يكون له
مسموع ومبصر في العدم إذ السمع والبصر من غير مسموع ومبصر محال وذلك يفضى
إلى القول العالم أو أن يكون ما فيه مسموعا ومبصرا في العدم وكلا الأمرين
محال وأيضا فإنه إما أن يشترط البنية المخصوصة للإدراك أو ليس
فإن اشترط
فإثبات الإدراك للبارى يوجب له البنية المخصوصة وهو متعذر والقول بعدم
الاشتراط ممتنع أيضا إذ يلزم منه الالتباس بين الإدراكات وأن تكون حاسة
واحدة مدركة بإدراكات مختلفة وهو ممتنع فإن البنية المخصوصة لا بد منها
فالسمع هو قوة مرئية في العصبة المنبسطة في السطح الباطن من صماخ الأذن من
شأنها أن تدرك الصوت المحرك للهواء الراكد في مقعر صماخ الأذن عند وصوله
إليه بسبب ما
والبصر هو عبارة عن قوه مرتبة في عصبة مجوفة من شأنها أن تدرك ما ينطبع في
الرطوبة الجليدية من أشباح صور الأجسام بتوسط المشف
والشم عبارة عن قوة مرتبة في زائدتى مقدم الدماغ من شأنها إدراك ما يتأدى
إليها بتوسط الهواء من الأراييح
والذوق عبارة عن قوة مرتبة في العصبة البسيطة على السطح الظاهر من اللسان
من شأنها إدراك ما يرد عليها من الطعوم يتوسط ما فيه من الرطوبة الغذائية
واللمس عبارة عن قوة منبثة في كل البدن من شأنها إدراك ما يرد عليه من
خارج من الكيفيات الملموسة وهى الحرارة والبرودة واليبوسة
وإذا لم يكن في الإدراك بد من الآلات والأدوات امتنع القول
بثبوتها في حق
البارى تعالى كيف وأن ما ذكرتموه ينتقض عليكم بباقى الادراكات وغيرها من
الكمالات كما سلف
والجواب أما ما قيل من أن السمع والبصر ليسا
بزائدين على نفس العلم فقد قال بعض الأصحاب في الجواب ههنا إنه لو لم يكن
كذلك وإلا لما وقعت التفرقة بين ما علم بالبرهان أو الخبر وبين ما حصل
بالعين والبصر ولا محالة أن هذه التفرقة مما يشهد بصفدقها نظر ذوى الألباب
فإنكارها مما لا سبيل إليه إلا عن جحد أو عناد
لكنه مما لا ثبوت له
على محك النظر إذ الخصم يقول وإن سلم التفرقة بمنع عودها إلى العلم
والإدراك بل ما تشعر به النفس عند الخبر اليقينى بأن زيدا مثلا على صورة
كذا أو كذا ليس يختلف عند النظر والمشاهدة بالبصر وإنما الاختلاف والتفرقة
عائدان إلى نفس المحل الذى هو واسطة حصول العلم من البصر وغيره أو إلى
الجملة والتفصيل أو الاطلاق والتقييد أو العموم والخصوص وبالجملة إلى
المحل الذى هو متعلق العلم في الحالتين وذلك بأن يكون ما حصل بالبصر أو
السمع مفصلا أو مقيدا أو خاصا وما حصل بالبرهان والخبر لم يكن إلا مجملا
أو مطلقا أو غير ذلك وذلك مما لا يدل على أن ما حصل بالبصر أو السمع خارج
عن جنس العلم أو نوعه وهو كما لو علم بطريق خاص إما بالدليل أو غيره أن كل
منقسم بمتساويين فهو زوج واتفق أن ما في يد زيد مثلا منقسم بمتساويين فأنه
من جهة العموم معلوم
أنه زوج لضرورة العلم بأن كل منقسم
بمتساويين زوج وما علم بالبصر بعد ذلك ليس هو ما كان معلوما أولا وإنما
الحاصل ثانيا هو نفس العلم بخصوصه وبكونه منقسما بمتساويين واختلاف
متعلقات العلم واختلاف طرق تحصيلها مما لا يؤثر اختلافا في نفس العلم
المتعلق بها
فالطريق في الأنفصال أن يقال الإنسان قد يجد من نفسه
معنى زائدا عند السمع والبصر على ما كان قد علمه بالدليل أو الخبر وذلك
مما لا مراء فيه كما سبق فالمعنى بالإدراك ليس إلا هذا المعنى وسواء سمى
ذلك علما أو إدراكا وسواء كان متعلقه أمرا تقييديا أو تفصيليا أو معنى
خاصا أو غير ذلك من المتعلقات فإن حاصل ذلك ليس يرجع إلا إلى محض
الاطلاقات ومجرد العبارات فلا مشاحة فيها بعد فهم معانيها فإن ذلك مما لا
يقدح في الغرض بإبطاله أو تصحيحه وعند ذلك فلا مبالاة بمن اعتاص على فهمه
قبول هذا الاعتقاد وشمخ أنفه عن أن ينقاد بعد ظهور الحقائق وانكشاف غور
الدقائق ومن رام في الانفصال عن هذا الخيال غير ما أشرنا إليه فقد كلف
نفسه شططا وذلك على النبيه مما لا يخفى
وما قيل من أنه لو كان
الإدراك زائدا على نفس العلم لجاز أن يكون بين يدى إنسان سليم البصر فيل
لا يدركه لجواز أن لا يخلق له الإدراك به وهو محال قلنا ادعاء كونه محال
إما أن ينظر فيه إلى الإحالة العقلية أو العادية فإن كان الأول
فهو استرسال لما هو غير مسلم وإن كان الثانى فهو بعينه لا محالة
لازم في
خلق الادراك فإنه كما يستحيل عادة انتفاء الإدراك للفيل عند حضوره بين يدى
ذى البصر السليم كذا يستحيل القول بانتفاء خلق الادراك في مثل تلك الحالة
ايضا وان نظر في ذلك الى جهة الجواز العقلى فهو ايضا ما نقوله في الأدراك
فإنه كما يجوز أن لا يخلق له الأدراك عقلا يجوز أن لا يدركه عقلا كيف وأن
هذا لازم على الخصم في العلم أيضا فما هو عذره في العلم هو عذرنا في
الإدراك
وأما تفسير الإدراك بنفى الآفة عمن له الحياة فمما لا
يستقيم إذ قد بينا أن الإنسان يجد من نفسه تفرقة بين الإدراكات وذلك لا بد
وأن يكون بأمر زائد على الحياة وانتفاء الآفة وألا لما وقع الفرق ثم كيف
يصح أن يقال السميع والبصير هو الذي لا آفة به ويقال لمن يسمع وبصر وهو
مئوف ناقص
فإن قيل ليس السميع هو من سلبت عنه الآفة مطلقا بل من
سلبت عنه الآفة في محل السمع وكذا في كل إدراك على حسبه فهو متهافت شنيع
فإن من قال السمع هو نفى الآفة في محل السمع فكأنه قال السميع هو من له
السمع في محل السمع ولو قال السميع هو من له السمع لقد كان ذلك كافيا عن
ذكر المحل وإذا كان كافيا فكأنه قال السميع هو الذي لا آفة به إذ ذاك فرجع
الكلام الأول بعينه ثم ان العقل السليم يقضى بوهاء قول من فسر السمع
والبصر بنفى الآفة دون العلم والقدرة وغيرها
من الصفات مع أنه لو
سئل عن الفرق لم يجد عنه مخلصا بل كل ما تخيل من منع تفسير العلم والقدرة
بانتفاء الآفة فهو بعينه في الإدراك حجة لنا
وأما القول بأن ذلك
يفضى إلى قدم المبصرات والمسموعات فمن عرف كيفية تعلق العلم بها في القدم
كما أشرنا إليه لم يخف عليه دفع هذا الإشكال ههنا فإن تعلق السمع والبصر
بمتعلقاتهما الحادثة لا يتقاصر عن تعلق العلم بمتعلقاته الحادثة فما به
دفع الإشكال ثم به دفعه ههنا
وأما إشتراط البنية المخصوصة فمما لا
سبيل إليه إذ القائل به معترف أن الإدراك قائم بجزء واحد من جملة المدرك
وعند ذلك فلا يخفى أنه لا أثر لاتصال محله بما جاوره إذ الاجسام لا يؤثر
بعضها في بعض فيما يرجع إلى ما يقوم بها من الأعراض بل الجوهر الفرد يكون
على صفته عند المجاورة به لغيره في حال انفراده وإذا جاز قيام الإدراك
بجزء واحد في حال انفراده واتصاله لزم أن لا تكون البنية المخصوصة شرطا
ولا يلزم على ما ذكرناه الاجتماع وسائر الأعراض الإضافية حيث إنها تقوم
بالجوهر عند إضافته وضمه إلى غيره ولا تقوم به عند أنفراده لأنا نقول
الكون القائم بكل جرم في حالة الاجتماع هو بعينه قائم في حالة الافتراق
مطلقا والمختلف إنما هو الأسماء فإن ما هو قائم عند ضميمة غيره إليه يسمى
اجتماعا وبعد الافتراق لا يسمى كذلك وإن سلم أنه لا يبقى لكنه غير لازم
وذلك أن الصفات العرضية منها ما يقتضى لذاته الضم والاجتماع بين المحال
كبعض الأمور الإضافية ومنها ما لا يقتضى ذلك كما
في السواد
والبياض ونحوها مما ليس بصفة إضافية ولا يلزم من كون الصفات الإضافية على
ما ذكر أن يكون غيرها مثلها ولا يخفى أن الإدراك ليس من ذلك القبيل
المفتقر إلى الجمع والضم في الأجرام
ومما يدل على أن الإدراك غير
مفتقر إلى البنية ويخص البصريين القائلين بكون البارى مدركا أن يقال لو
كانت البنية شرطا لوجب طردها شاهدا وغائبا كما ذهبوا اليه واعتمدوا عليه
في الاشتراط ولو كان كذلك لوجب كون البارى ذا بنية مخصوصة لضرورة الأعتراف
بكونه مدركا وإذا ذاك فينقلب الإلزام وتتساوى فيه الأقدام
فإن قيل
اشتراط البنية إنما هو في حق المدرك بادراك فلا يلزم البنية في حقه تعالى
فانظر إلى هؤلاء كيف ساقهم الغى إلى كشف عوراتهم وإبداء زلاتهم ومناقضة
أصولهم ومخالفة رسومهم وتحملهم بالجهالة فيما لا يعلمون وإصرارهم على
الباطل فيما يقولون حيث إنهم جعلوا الحياة شرطا في الشاهد لكون العالم
عالما بعلم ثم طردوا ذلك في حق الغائب حتى قالوا إن الحياة شرط كونه عالما
وإن لم يكن عالما بعلم ولم يجعلوا البنية شرطا لكون المدرك مدركا متى لم
يكن مدركا بإدراك لضرورة كونها شرطا لكون المدرك بإدراك ولم يعلموا أنهم
في ذلك متحكمون وبدعواه متجاهلون وأنهم لو سئلوا عن الفرق لم يجدوا إليه
سبيلا
وأما القول بأن ذلك يفضى إلى الالتباس بين الإدراكات غير
مستقيم وذلك من جهة أن الالتباس فيها لا يكون بسبب اتحاد محلها وإلا لما
تصور قيام عرضين
متغايرين بمحل واحد وإلا وهما متشابهان ولا يخفى
أن قيام الطول مثلا والسواد وغيره من الكيفيات بمحل واحد جائز وإن قرر أنه
لاشتباه فعلى هذا ليس الالتباس بين الأشياء إلا لما يقع بينها من التشابه
في أنفسها ولا يخفى انتفاء التشابه بين الإدراكات في أنفسها وأن الحاصل من
كل واحد غير ما حصل من الآخر
وعلى ما أشرنا إليه من التحقيق يتبين
أن ما ذكروه في السمع والبصر وغيرهما من الإدراكات لم يخل إما أن يكون
إدراكها لشئ بخروج شئ منها إليه أو بإتصال شئ منه بها فإن قيل بالأول
فالخارج اما جوهر وإما عرض لا جائز أن يكون جوهرا وإلا فهو إما متصل أو
منفصل لا جائز أن يكون متصلا وإلا لزم أن يكون قد خرج من الجرم الصغير جرم
ملأ نصف كرة العالم واتصل بالثوابت وهو متعذر وإن كان منفصلا فهو باطل
أيضا وإلا لأحس به الخارج منه وللزم ألا يدرك المدرك بسبب أن ما به
الإدراك خارج عنه وأن لا يختلف الشئ المدرك أو المسموع بسبب القرب والبعد
لكون ما به الإدراك قد أحاط بهما
هذا إن كان جوهرا وإن كان عرضا فهو
ممتنع أيضا إذ العرض لا تحرك له بنفسه وان تحرك بمحله أوجب المحالات
السابق ذكرها فإن قيل إن ما بين البصر والمبصر من الهواء المشف يستحيل آلة
دراكه قلنا فيلزم أن تكون استحالته عند اجتماع المبصرين أشد وإذ ذاك فيجب
أن يكون إدراك الواحد للشئ عند الاجتماع
أشد من حالة الانفراد
لكون الاستحالة في الآلة الدراكة أشد وللزم أن يضطرب الشئ المبصر عند
تشويش الجو واضطراب الرياح بسبب تجدد الآلة الدراكة وهو ممتنع هذا إن قيل
بخروج شئ من البصر إلى المبصر
وإن قيل إن شيئا من المبصر يتصل
بالبصر بحيث ينطبع فيه ويدركه فإما أن يكون ذلك على جهة الانتقال
والانفصال أو على الانطباع والتمثيل من غير انفصال شئ من المبصر وعلى كلا
التقديرين فهو باطل وإلا للزم ان لا يدرك الشئ المرئى إلا على نحو ما
انطبع منه في البصر من غير زيادة ولا نقصان ولو كان كذلك لما رؤى الحمل أو
الجبل على هيئته بل على نحو ما ينطبع منه في البصر وهو هوس ثم إنه لا جائز
أن يكون المنطبع منتقلا ولا فهو إما جوهر وإما عرض لا جائز ان يكون جوهرا
لما أسلفناه وأيضا فإنه يلزم منه أن تحترق العين عند كون المرئى نارا وهو
ممتنع وإن كان عرضا فهو أيضا باطل لما سلف فتبين من هذا أن الادراك ليس
إلا معنى يخلقه الله تعالى للمدرك مع قطع النطر عن الانتقال والانطباع في
الآلات والأدوات وحيث لم يكن للعين أو اليد وغير ذلك من الجوارح قوة
الإدراك فليس لعدم صلاحيته للإدراك بل لأن الله تعإلى لم يخلق له الإدراك
وهذا الأصلا عظيم مطرد عند المحققين من أهل الحق في سائر الإدراكات
وأما ما أشير إليه من النقض بسائر الإدراكات فقد سبق وجه
الانفصال عنه فلا حاجة إلى إعادته
وعند هذا فيجب أن يعلم أن المستند في إثبات صفة الحياة ما هو المستند في
الإدراكات وباقى الصفات
خاتمة جامعة لهذا القانون
إن قيل فهل للبارى تعالى أخص وصف يتميز به عن المخلوقاتوهل يجوز أن يكون له صفة زائدة على ما أثبتموه من الصفات
وهل الصفة نفس الوصف أم غيره
وإن كانت غيره فهل هى عين الموصوف أم غيره أم لا هى هو ولا هى غيره
قلنا أما السؤال الأول
فقد قال بعض الأصحاب فيه إنه لا بد من صفة وجودية إذ التمييز بين الذوات غير حاصل بما يتخيل من الأمور السلبية النفيية كما في قولنا إنه لا حد له ولا نهاية وليس بجسم ولا عرض ونحو ذلك
لكن هل يجوز ان يدرك أم لا اختلفوا فقال بعضهم إن استدعاء التمييز بالوصف الأخص إنما يكون عند الاشتراك بين الذوات والبارى تعالى مباين بذاته لجميع مخلوقاته وأنه ليس بمجانس لها وإلا للزم أن يشاركها في كونها جواهر وأعراضا وكل ذلك محال كما سيأتى وهو الأغوص
وأما السؤال الثانى
فمما اختلف فيه ايضا فقال
بعضهم لا يجوز أن يكون له صفة زائدة على ما أثبتناه من جهة أن الدليل الذى
دل عليها لم يدل على غيرها وأيضا فإنه لو جاز أن يكون له صفة أخرى لم يخل
إما أن تكون صفة كمال أو نقصان فإن كانت صفة كمال فعدمها في الحال نقصان
وان كانت صفة نقصان فثبوتها له ممتنع وهذا فيه نظر فإن غاية ما يلزم من
انتفاء دلالة الدليل على الوصف انتفاء العلم بوجوده وذلك مما لا يلازمه
القو ل بنفى تجويزه وليس يلزم من كونه جائزا أن يكون معدوما حتى يقال إن
عدمه يكون نقصا نعم لو قيل إن له صفة جائزة له وليست في الحال ثابتة له
لقد كان ذلك ممتنعا
فإذا الأقرب ما ذكره بعض الأصحاب وهو أن ذلك
جائز عقلا وان لم نقض بثبوته لعدم العلم بوقوعه عقلا معلا وانتفاء الإطلاق
به شرعا وذلك مما لا يوجب لواجب الوجود في ذاته نقصا إلا أن يكون ما هو
جائز له غير ثابت
ومن الأصحاب من زاد على هذا وأثبت العلم بوجود
صفات زائدة على ما أثبتناه وذلك مثل البقاء والوجه والعينين واليدين ومن
الحشوية من زاد على ذلك حتى
أثبت له نورا وجنبا وقدما والاستواء على العرش والنزول إلى سماء
الدنيا وعند التحقيق فهذه الصفات مما لا دليل على ثبوتها
أما البقاء فليس زائدا على معنى استمرار الوجود فمعنى قولنا إن الشئ باق
أنه مستمر الوجود وإنه ليس بباق أنه غير مستمر الوجود وذلك لا يزيد على
نفس الوجود فيما يعرض من الأحوال المعددة والمدد المسرمدة ثم ولو كان
البقاء صفة زائدة على نفس الوجود فإما أن يكون موجودا او معدوما فإن كان
معدوما فلا صفة وان كان موجودا لزم ان يكون له بقاء وإلا فلا يكون مستمرا
وذلك في صفات البارى تعالى محال وإن كان له بقاء فالكلام في ذلك البقاء
كالكلام في الاول وهلم جرا وذلك يفضى إلى ما لا نهاية له وهو محال
ثم يلزم منه أن يكون البقاء قائما بالبقاء وذلك ممتنع إذ ليس قيام أحدهما
بالآخر بأولى من العكس لاشتراكهما في الحقيقة واتحادهما في الماهية وهذا
الذى ذكرناه مما لا يفرق فيه بين موجود وموجود لا شاهدا ولا غائبا فإذا
ليس البقاء صفة زائدة على نفس الباقى
وأما ما قيل بثبوته من باقى الصفات
فالمستند فيها ليس إلا المسموع المنقول دون قضيات العقول والمستند في
الوجه
قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وفي اليدين قوله تعالى موبخا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى وفي العينين قوله تعالى فإنك بأعيننا وقوله تجرى بأعيننا وفي النور قوله تعالى نور السموات والأرض وفي الجنب قوله تعالى يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وفي الساق قوله تعالى يوم يكشف عن ساق وفي القدم قوله عليه السلام وإذا كان يوم القيامة واستقر أهل الجنان في نعيمهم وأهل النيران في حميمهم قالت النار هل من مزيد فيضع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط أي حسبى حسبى وفي النزول قوله عليه السلام إن الله ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له وفي الاستواء قوله تعالى ثم استوى على العرش و إلى غير ذلك من الآيات
واعلم أن هذه الظواهر وإن وقع الاغترار بها بحيث
يقال بمدلولاتها ظاهر من جهة الوضع اللغوى والعرف الاصطلاحى فذلك لا محالة
انخراط في سلك نظام التجسيم ودخول في طرف دائرة التشبيه وسنبين ما في ذلك
من الضلال وفي طيه من المحال إن شاء الله بل الواجب أن يقال ليس كمثله شئ
وهو السميع البصير
فإن قيل بأن ما دلت عليه هذه الظواهر من
المدلولات وأثبتناه بها من الصفات ليست على نحو صفاتنا ولا على ما نتخيل
من احوال ذواتنا بل مخالفة لصفاتنا كما ان ذاته مخالفة لذواتنا وهذا مما
لا يقود إلى التشبيه ولا يسوق إلى التجسيم
فهذا وإن كان في نفسه
جائزا لكن القول باثباته من جملة الصفات يستدعى دليلا قطعيا وهذه الظواهر
وإن أمكن حملها على مثل هذه المدلولات فقد أمكن حملها على غيرها أيضا ومع
تعارض الاحتمالات وتعدد المدلولات فلا قطع وما لا قطع عليه من الصفات لا
يصح إثباته للذات
فإن قيل وما هذه الاحتمالات التى بتدونها التى تعنونها قلنا
أما لفظ اليدين فإنه يحتمل القدرة وهذا يصح أن يقال فلان في يدى
فلان إذا
كان متعلق قدرته وتحت حكمه وقبضته وإن لم يكن في يديه اللتين هما بمعنى
الجارحتين أصلا وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام قلب المؤمن بين إصبعين من
أصابع الرحمن
فإن قيل يلزم من ذلك إبطال فائدة التخصيص بذكر خلق آدم
باليدين من حيث إن سائر المخلوقات إنما هى مخلوقة بالقدرة القديمة فإذا
قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى أي بقدرتي لم يكن له معنى
قلنا
لا يبعد أن تكون قائدة التخصيص بالذكر التشريف والاكرام كما خصص المؤمنين
بلفظ العباد واضافهم بالعبودية إلى نفسه وكما أضاف عيسى والكعبة إلى نفسه
ولم تكن فائدة التخصيص بالذكر اختصاص ما أضافه إلى نفسه بالإضافة بل
التشريف والاكرام لا غير ثم إنا قد بينا ان للبارى تعالى قدرة وهى معنى
يتأتى به الإيجاد واليدان اما ان يتأتى بهما الايجاد والخلق او ليس فإن
تأتى بهما الايجاد فهى نفس القدرة لا زائدا عليها وإن اختلفت العبارات
الدالة عليها والقول بالتعدد في صفة القدرة مما لا سبيل إليه لما أشرنا
إليه وأما إن كانت مما لا يتأتى بها الإيجاد والخلق
فلا محالة أن
في حمل اليدين إلى غير القدرة ما يفضى إلى الكذب في الآية حيث أضاف الخلق
والإيجاد إليهما ولا محالة أن محذور إبطال فائدة التخصيص أدنى من المحذور
اللازم من الكذب وعلى تقدير التساوى فالاحتمال قائم والقطع منتف
وأما قوله تجرى بأعيننا فإنه يحتمل الحفظ والرعاية ولهذا تقول العرب فلان
بمرأى من فلان ومسمع إذا كان ممن يحوط به حفظه ورعايته ويشمله رفده
ورعايته وقد قيل إنه يحتمل أن يراد بالأعين ههنا على الخص ما انفجر من
الأرض من المياه وأضافها إلى نفسه إضافة التملك
وقوله ويبقى وجه ربك
فإنه يحتمل أن يكون المعنى بالوجه الذات ومجموع الصفات وحمله عليه أولى من
جهة أنه خصصه بالبقاء وذلك لا يختص بصفة دون صفة بل هو بذاته ومجموع صفاته
باق
وقوله الله نور السموات والأرض فإنه يحتمل أن يكون المراد به
أنه هادى أهل السموات والأرض ويكون اطلاق اسم النور عليه باعتبار هذا
المعنى
وقوله يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله فيحتمل أن يكون
المراد به أمر الله ونهية فيكون تقدير ذلك يا حسرتا على ما فرطت في امتثال
أوامر الله ونواهيه ويحتمل ان يكون المراد به الجناب ومنه يقال فلان لائذ
بجنب فلان اى بجنابه وحرمه
واما قوله يوم يكشف عن ساق فيحتمل أن
يكون المراد به الكشف عن ما في القيامة من الأهوال وما أعد للكفار من
السلاسل والأغلال ولهذا يقال قامت الحرب على ساق عند التحامها وتصادم
أبطالها واشتداد اهوالها
وقوله عليه السلام فيضع الجبار قدمه فى
النار فقد قيل يحتمل أن يراد به بعض الامم المستوجبين النار وتكون إضافته
القدم إلى الجبار تعالى إضافة التمليك وقد قيل يحتمل أن يكون المراد به
قدم بعض الجبارين المستحقين للعذاب الأليم بأن يكون قد ألهم الله النار
الاستزاده إلى حين استقرار قدمه فيها
وأما آية الاستواء فإنه يحتمل
أن يكون المراد التسخير والوقوع في قبضة القدرة ولهذا تقول العرب استوى
الأمير على مملكته عند دخول العباد تحت طوعه في مراداته وتسخيرهم في
مأموراته ومنهياته وإليه الإشارة بقول الشاعر ... قد استوى بشر على العراق
... من غير سيف ودم مهراق
وتكون فائدة التخصيص بذكر العرش التنبيه بالأعلى على الأدنى
فيما يرجع إلى الاستيلاء والاستعلاء
وأما خبر النزول فانه يحتمل أن يكون المراد النزول بمعنى اللطف والرحمة
وترك ما يليق بعلو الرتبة وعظم الشأن والاستغناء الكامل المطلق ولهذا تقول
العرب نزل الملك مع فلان إلى أدنى الدرجات عند لطفه به وإحاطته بعنايته
وانبساطه في حضرة مملكته وتكون فائدة ذلك انبساط الخلق على حضرة المملكة
بالتضرع بالدعوات والتبتل بالعبادات وغير ذلك من الرياضات في تحصيل
المقاصد والمطلوبات وإلا فلو نظر إلى ما يليق بمملكته وعلو شأنه وعظمته
لما وقع التجاسر على خدمته والوقوف بعتبته فإن العباد وعباداتهم من صومهم
وصلاتهم بالنسبة إلى عظمته وجلاله دون تحريك أنملة بعض العباد في معرض
الطاعة والخدمة لبعض ملوك البلاد ومن فعل ذلك فإنه يعد في العرف مستهينا
ومستهزئا بالمملكة وخارجا عن إرادة التعظيم فما ظنك بما هو في دون من
الرتبة
وأما التخصيص بسماء الدنيا فمن حيث إنها أدنى الدرجات
بالنسبة إلى رتبه العلى فلذلك جعل النزول إليها مبالغة في اللطف كما يقال
للواحد منا صعد إلى السماء
ونزل إلى الثرى إذ هى أدنى الدرجات
بالنسبة إلى رتبته في جانبى النزول والرفعة لما ذكرناه و خصص النزول
بالليالى دون الأيام من حيث إنها مظنة الخلوات ووقت التضرع والدعوات لخالق
البريات وقد قيل إنه يحتمل أن يكون المراد بنزول الله نزول ملك لله تجوزا
واستعارة كما قال وأسأل القرية أي أهل القرية وكقوله الذين يحادون الله
ورسوله أي أولياءه ويقول على لسانه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر
فأغفر له وذلك كما يقال نادى الملك وقال الملك كذا على كذا وإن كان
المنادى والقائل بذلك القول غيره
وليس تأويل هذه الظواهر وحملها على
هذه المحامل بمستبعد كما حمل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقوله ما
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم على معنى الحفظ
والرعاية وكما حمل قوله عز و جل على ما أخبر به نبيه عليه السلام من اتانى
ماشيا أتيت إليه هرولة على معنى التطول والإنعام فإن لم يقل بالتأويل ثم
وجب الا يقال به ههنا وإن قيل به ههنا وجب القول به ثم إذ لا فارق بين
الصورتين ولا فاصل بين الحالتين
وأما السؤال الثالث
فقد اضطربت آراء المتكلمين فيه
فذهبت المعتزلة إلى أن الصفة هى نفس الوصف والوصف هو خبر الخبير عمن اخبر
عنه بأمر ما كقوله إنه عالم أو قادر أو أبيض أو أسود ونحوه وأنه لا مدلول
للصفة والوصف إلا هذا ولربما احتجوا في ذلك بأنه لو خلق الله تعالى العلم
أو القدرة أو غيرهما من الصفات لبعض المخلوقات لم يصح تسميته باعبتار ذلك
واصفا ولو أخبر عنه بأنه عالم أو قادر أو غير ذلك صح القول بتسميته واصفا
والصفة يجب أن تكون ما يكون بها الواصف واصفا وليس على هذا النحو غير
القول والإخبار ولعل منهم من يستند في ذلك إلى النقل عن أهل الوضع أنهم
قالوا الوصف والصفة بمعنى واحد كما يقال الوجه والجهة والوعد والعدة وإذا
كان كذلك فالوصف هو القول والصفة هى القول لكونها في معناه ثم بنوا على
ذلك انتفاء الصفات عن البارى تعالى في الأزل لضرورة استحالة القول بوجود
الواصف في القدم
وأما معتقد أهل الحق فالصفة هى ما وقع الوصف مشتقا
منها وهو دال عليها وذلك مثل العلم والقدرة ونحوه فالمعنى بالصفة ليس إلا
هذا المعنى والمعنى بالوصف ليس
الا ما هو دال على هذا المعنى
بطريق الاشتقاق ولا يخفى ما بينهما من التغاير في الحقيقة والتنافر في
الماهية فالخلاف إن وقع فليس إلا في تسمية هذا المعنى صفة وحاصل النزاع في
ذلك مما لا مطمع فيه باليقين وانما هو مستند إلى الظن والتخمين ويكفى في
ذلك ما نقل عن العرب واشتهر استعماله في ألسنة أهل الأدب أن الصفة منقسمة
إلى خلقية لازمة وغير خلقية ثم فسروا الخلقية بالسواد والبياض ونحوه ولولا
أن ذلك جائز وإلا لما شاع ولا ذاع وعدم اشتقاق اسم منه لمن أبدعه وخلقه لا
يدل على امتناع تسميته صفة لجواز أن يكون اشتقاق ذلك الاسم من الوصف دون
الصفة ثم ولو وجب اشتقاق اسم الواصف من الصفة لكونه خالقها لوجب اشتقاق
اسم الزانى والمؤذى والمفسد للبارى تعإلى من الزنى والفساد والأذى لكونه
خالقها وهو محال
وما نقل عن العرب من قولهم إن الوصف والصفة بمنزلة
الوعد والعدة وهما بمنزلة واحدة يحتمل أن يكون المراد بذلك التسوية بينهما
في المصدرية فإنه يصح أن يقال وصفته وصفا ووصفته صفة كما يقال وعدته وعدا
ووعدته عدة أو أنهم أرادوا بقولهم أن الوصف هو الصفة للواصف المخبر فإن
قيامه به لا محالة صفة له والواجب جعل ما صح نقله عنهم من هذا القبيل على
مثل هذه المعانى أو عينها جمعا بين النقلين وعملا بكلا الدليلين
وإذا عرف أن الصفة غير الوصف فهل هى نفس الموصوف أم غيره أم لا هى هو ولا
هى غيره فالذى ذهب إليه الشيخ أبو الحسن وعامة الاصحاب أن من الصفات ما
يصح أن يقال هى عينه وذلك كالوجود ومنها ما يقال إنها غيره وهى كل صفة
أمكن مفارقتها
للموصوف بجهة ما كما في صفات الفعال من كونه خالقا
ورازقا ونحوه ومنها ما لا يقال إنها عينه ولا غيره وهى كل صفة امتنع القول
بمفارقتها بوجه ما كالعلم والقدرة وغيرهما من الصفات النفسية لذات واجب
الوجود بناء على أن معنى المتغايرين كل موجودين صحت مفارقة أحدهما للآخر
بجهة ما كالزمان والمكان ونحوه وهذا الكلام بعينه جار في تغاير الصفات
النفسية بعضها مع بعض أيضا وهذا مما لا أرى حاصله يرجع إلى أمر يقينى ولا
إلى معنى قطعى وإنما هو راجع إلى أمر اصطلاحى والواجب أن يجرد النظر إلى
التحقيق ويكشف عن غور مزلة الطريق فنقول
الواجب أن كل ذات قامت بها
صفات واجبة زائدة عليها فالذات غير الصفات وكذا كل واحد من الصفات غير
الأخرى إن اختلفا بالذوات بمعنى أن حقيقة كل واحد والمفهوم منه عند
انفراده غير مفهوم الآخر لا محالة نعم إن لم يصح اطلاق اسم الغيرين ولا
القول به صفة عن ذات الله تعالى وصفاته مع الاعتراف بكونها مختلفة الحقائق
والذوات لعدم ورود السمع به فهو جواب لكنه مما لا يقدح في المطلوب
وعند ذلك فلا بد من التنبيه لدقيقة وهو أنه وان كانت الصفات غير
ما قامت
به من الذات فالقول بأنها غير مدلول الاسم المشتق منها أو ما وضع لها
وللذات من غير اشتقاق وذلك مثل صفة العلم بالنسبة إلى مسمى العالم أو مسمى
الإله غير صحيح وكذلك لا يصح أن يقال بأنها عينه أيضا فإنها إدراك جزء
ومعنى ما قيل إنها ليست عينه أو غيره فعلى هذا وإن صح القول بأن علم الله
تعالى غير ما قارنه من الذات لا يصح أن يقال إن علم الله تعالى غير مدلول
اسم الله ولا عينه إذ ليس هو غير مجموع الذات مع الصفات وأيضا فإنه لو قطع
النظر عن الذات أو بعض الصفات لما كان الباقى هو مدلول اسم الإله ولعل هذا
ما أراده الحذاق من الأصحاب في أن الصفات النفسية لا هى هو ولا هى غيره
وهذا آخر ما أردناه ذكره من هذا القانون والله المستعان
القانون الثالث
في وحدانية البارى تعإلىرأى الفلاسفة الإلهيين
وبيان استحالة القول باجتماع الإلهين لكل واحد من صفات الإلهية ما لصاحبهوقد سلك الفلاسفة طريقا في التوحيد حاصله يرجع إلى امتناع وقوع الشركة في نوع واجب الوجود واستحالة وجود واجبين وقد أشرنا إليها في مبدأ قانون الصفات وإلى ما يرد عليها من الاعتراضات فلا حاجة إلى ذكرها ثانيا
وأما المتكلمون فقد سلك عامتهم في الإثبات مسلكين ضعيفين
المسلك الأول أنهم قالوا لو قدرنا وجود الإلهين وقدرنا أن أحدهما أراد تحريك جرم ما والأخر أراد تسكينه فإما أن تنفذ إرادة كل واحد منهما أو لا تنفذ ولا لواحد منهما أو لأحدهما دون الأخر فإن نفذت إرادتهما أفضى ذلك إلى اجتماع الحركة والسكون في شئ واحد في حالة واحدة وذلك محال وان لم تنفذ ارادتهما أفضى إلى عجز كل واحد منهما و إلى أن يكون الجرم الواحد يخلو من الحركة والسكون معا وهو محال ايضا
وان نفذت ارادة أحدهما دون
الآخر أفضى إلى تعجيز احدهما ولو عجر أحدهما لكان عاجزا بعجز قديم والعجز
لا يكون الا عن معجوز عنه وذلك يفضى إلى قدم المعجوز عنه وهو ممتنع
لكن منشأ الخبط ومحز الغلط في هذا المسلك إنما هو في القول بتصور اجتماع
إرادتيهما للحركة وليس ذلك مما يسلمه الخصوم ولا يلزم من كون الحركة
والسكون ممكنين وتعلق الإرادة بكل واحد منهما حالة الانفراد أن تتعلق بهما
حالة الاجتماع ووزانه ما لو قدرنا ارادة الحركة والسكون من أحدهما معا
فإنه غير متصور ولو جاز تعلقها بكل واحد منهما منفردا وليس هذا إحالة لما
كان جائزا في نفسه فان ما كان جائزا هو إرادته منفردا والمحال إرادته في
حال كونه مجامعا وبهذا يندفع قول القائل إن ما جاز تعلق الارادة به حالة
الانفراد جاز تعلقها به حالة الاجتماع إذ الاجتماع لا يصير الجائز محالا
وهذا الكلام بعينه في الإرادة هو أيضا لازم في صفة القدرة وأما القول بأن
عجز احدهما يستدعى عجزا قديما و معجوزا عنه فيلزم مثله في القدرة فإن
القادر قادر بقدرة قديمة فإن استدعى العجز قدم المعجوز عنه وجب أن تستدعى
القدرة قدم المقدور
فإن قيل القدرة ليس معناها غير التهيؤ
والاستعداد للإيجاد والإحداث وذلك لا يستدعى قدم المقدور قيل والعجز لا
معنى له إلا عدم القدرة على الإحداث وذلك أيضا لا يوجب قدم شئ ما لا بل
أولى فإن وجود القدرة إذا لم يستدع مقدورا فعدمه بعدم الاستدعاء أولى
المسلك الثانى هو أنهم قالوا الطريق الموصل إلى معرفة البارى
تعالى ليس
إلا وجود الحادثات لضرورة افتقارها إلى مرجح ينتهى الأمر عنده وهى لا تدل
على أكثر من واحد
وهو أيضا مما لا يقوى فإن حاصلة يرجع إلى نفى
الدليل الدال على وجود الاثنين ولا بد فيه من الاستناد إلى البحث والتفتيش
وذلك غير يقينى على ما لا يخفى ثم ولو قدر انتفاء كل دليل فذلك مما لا
يكفى من رام نفى المدلول لجواز وجوده في نفسه وانتفاء دليله
فالصواب في هذا الباب
أن يقال لو قدرنا وجود الإلهين لم يخل اما أن يشتركا من كل وجه أو يختلفا
من كل وجه أو يشتركا من وجه دون وجه فإن كان الاول فلا تعدد ولا كثرة وان
كان الثانى فلا محالة أنهما لم يشتركا في وجوب الوجود ولا فيما يجب لله من
الكمالات ويستحيل عليه من الصفات وإذ ذاك فأدحهما لا يكون إلها وإن كان
الثالث فتخصيص ما به الاشتراك مما به الافتراق في كل واحد منهما اما أن
يستند اليه أو إلى خارج عنه فان استند اليه فإما أن يكون ذلك له بالذات أو
بالإرادة لا جائز أن يكون له لذاته والا لوجب الاشتراك فيه لضرورة أن
المقتضى له فيهما واحد وإن كان ذلك له بالإرادة استدعى كونه متحققا
وموجودا دون ما خصصه وهو محال وان كان ذلك مستندا إلى خارج لزم أن يستندا
في وجوبهما كل واحد على صاحبه وهو ممتنع ومع كونه ممتنعا فيلزم أن يكون كل
منهما ممكنا وجوده وهو محال
وأيضا فإنا لو قدرنا وجود إلهين
وقدرنا وجود حادث فإما أن يستند في وجوده إليهما أو إلى أحدهما لا جائز أن
يستند إليهما فإنه إما أن يضاف حدوثه بكليته إلى كل واحد منهما بجهة
الاستقلال أو يكون مضافا إليهما على وجه لو قدر عدم أحدهما لم يكن موجودا
فإن كان القسم الأول فهو ظاهر الإحالة ثم يلزم إسقاط تأثير أحدهما وليس ما
يفرض اسقاط تأثيره بأولى من الآخر وذلك يفضى إلى إسقاط تأثيرهما معا
لاستحالة الجمع بين التأثير واستقلال أحدهما وان كان القسم الثانى فهو
محال أيضا فإن إيجاد كل واحد منهما ليس إلا بالإرادة والقصد لا بالطبع
والذات لضرورة كون الموجود المفروض حادثا كما سنبينه وإذ ذاك فيمتنع قصد
كل واحد منهما إلى الإيجاد لتعذر استقلاله به ويتعذر قصده أيضا إلى بعض
الإيجاد لتعذر وقوعه به وعلى هذا يمتنع وقوع الايجاد لتعذر وقوع قصديهما
وقد فرض وقوع الإيجاد
ولا جائز أن يقال ما المانع من أن يقصد كل
واحد منهما مشاركة الآخر لأن القصد إما للمشاركة في نفس القدرة أو في نفس
الفعل فان كان الأول فمستحيل إذ القدرة الإلهية غير مخصصة له وإلا افضى
إلى التسلسل فلا يتصور قصد الشركة فيها وان كان الثانى فلا محالة أن قصد
الشركة غير قصد نفس المشترك فيه وقصد المشترك فيه يعنى أن يكون مضافا في
الإيجاد والإحداث إلى أحدهما على وجه الاستقلال من غير أن يكون للآخر
تأثير ألبته وليس القول بإضافته إلى احدهما على الخصوص بأولى من الآخر
لكونهما مثلين وذلك يفضى إلى القول بانتفاء الحوادث وهو محال
فإن
قيل قد صادفنا في العالم خيرا وشرا وكل واحد منهما يدل على مريد له ولا
محالة أن مريد الشر لا يكون مريدا للخير وكذا بالعكس واختلاف المرادات يدل
على اختلاف المريد
قلنا الاستدلال على وجود الإله إنما هو مستند إلى
الجائزات وافتقارها إلى المرجح من حيث هى جائزة ولا اختلاف بينها فيه
والفاعل لها إنما يريدها من حيث وجودها والوجود من حيث هو وجود خير محض لا
شر فيه وهو ما يقع مرادا للبارى تعالى وأما الشر من حيث هو شر فليس هو
مستندا إلا إلى اختلاف الأغراض أو إلى قول الشارع افعل أو لا تفعل كما
سنبينه وذلك مما لا يوجب كونه شرا في نفسه فإذا ليس الشر بما هو شر ذاتا
يطلب حدوثها ولا عدمها حتى يقال إن ما اقتضاه يجب أن يكون غير ما اقتضى
نفس الخير ثم لو قدرنا أن ذلك مما يصح قصده وأنه ذات وأنه حقيقة لكن لا
يخفى التحكم بدعوى انتسابه في الإيجاد إلى غير ما نسب إيجاد الخير له بل
لا مانع من أن يكون إيجادهما بإيجاد موجد واحد إلا على فاسد أصل القائل
بالصلاح والأصلح وتحسين الفعل لذاته وتقبيحه وسيأتى وجه إبطاله إن شاء
الله
وهذا آخر ما أردنا ذكره ههنا والله الموفق للصواب
القانون الرابع
في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أ في بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانهالقاعدة الأولى
في بيان ما يجوز على الله تعالىوقد أطبقت الأشاعرة وغيرهم من أهل الحق على جواز رؤية البارى عقلا ووقوعها شرعا واجمعت الفلاسفة وجماهير المعتزلة على انتفاء ذلك مطلقا
ومن أهل الضلال من فصل وقال إنه يرى نفسه وإنما يمتنع ذلك على غيره
والواجب البداية بتقديم النظر في طرف الجواز العقلى أولا ثم في وقوعه شرعا ثانيا وقد سلك المتكلمون في ذلك من أهل الحق مسالك لا تقوى
المسلك الأول
هو ما اشتهر من قولهم الرؤية تتعلق بالموجودات المختلفة كالجواهر والأعراض ولا محالة أن متعلق الرؤية فيها ليس إلا ما هو ذات ووجود وذلك لا يختلف وان تعددت الموجودات وأما ما سوى ذلك مما يقع به الاتفاق والافتراق فأحوال لا تتعلق بها الرؤية لكونها ليست بذوات ولا وجودات وإذا كان متعلق الرؤية ليس إلا نفس الوجود وجب أن تتعلق الرؤية بالبارى لكونه لا محالة موجودا
ومن نظر بعين التحقيق علم أن المتعلق به منحرف عن سواء الطريق
وذلك أنه وإن سلم جواز تعلق الرؤية بالجواهر والأعراض مع امكان النزاع فيه
فهو لا محالة إما أن يكون من المعترف بالأحوال أو قائلا بنفيها فإذا كان
من القائل بها فالوجود الذى هو متعلق الرؤية حينئذ لا بد وأن يكون هو نفس
الموجود لا زائدا عليه وإلا كان حالا وخرج عن أن يكون متعلق الرؤية وإذا
كان هو نفس الموجود وليس بزائد على الذات فلا بد من بيان الاشتراك بين
الذوات الموجودة شاهدا وغائبا والا فلا يلزم من جواز تعلق الرؤية بأحد
المختلفين جواز تعلقها بالآخر ولا يخفى أن ذلك مما لا سبيل اليه والا كان
البارى ممكنا لمشاركته الممكنات بذواتها في حقائقها وهو متعذر
ثم
ولو قيل ليس متعلق الإدراك هو نفس الوجود بل ما وقع به الافتراق والاختلاف
بين الذوات كما ذهب اليه بعض الخصوم من المعتزلة لم يجد في دفع ذلك مستندا
غير الاستناد إلى محض الدعوى وليس من الصحيح ما قيل في دفعه من أن الإدراك
اخص من العلم والعلم عند الخصم مما لا يصح تعلقه بالأحوال على حيالها
فيمتنع دعوى تعلق ما هو أخص بها فإنه لا يلزم من انتفاء تعلق العلم بشئ
على حياله وان كان أعم إنتفاء تعلق الأخص به اللهم الا ان يكون الأعم جزءا
من معنى الأخص ويكون تعلق الأخص به من جهة ما اشتمل عليه من حقيقة ما تخصص
به من المعنى العام إذ هو نفس حقيقة ما منع من تعلقه وهو تناقض اما ان كان
الأعم كالعرض العام للأخص أو هو داخل في معناه لكن تعلق المتعلق ليس إلا
من جهة خصوصه لا من جهة ما يتضمنه من المعنى
العام فلا مانع من ان يكون تعلقه بالشئ على حياله وان كان تعلق
المعنى العام به لا على حياله
ثم ولو قدرنا امتناع تعلق الاخص بالشئ على حياله لضرورة امتناع تعلق الأعم
به على حياله فحاصله إنما هو راجع إلى مناقضة الخصم في مذهبه وهو غير كاف
فيما يرجع إلى الاستقلال بتحصيل المطلوب لضرورة تخطئة الخصم فيما وقع
مستندا له وهو من خصائص مذهبه ولهذا لو اعترف بخطئه فيما ذهب إليه لم يك
ما قيل مثمرا للمطلوب ولا لازما عليه كيف وأن ذلك وإن كان مناقضا لبعض
الخصوم كالجبائى ومن تابعه لضرورة منعه من تعلق العلم بما وقع به الاتفاق
والافتراق على حياله فهو غير لازم في حق غيره اللهم إلا أن يكون قائلا
بمقالته وذلك مما لا سبيل إلى دعوى عمومه
وان كان من القائلين بنفى
الأحوال فما وقع به الاختلاف بين الذوات حينئذ لا مانع من أن يكون من جملة
المصحح للرؤية لكونه ذاتا وإذ ذاك فلا يلزم منه جواز تعلق الرؤية بواجب
الوجود إلا أن يبين أن ما كان مصححا للرؤية في باقى الذوات متحقق في حق
واجب الوجود وهو متعذر
ولما تخيل بعض الأصحاب زيغ هذه الطريقة عن
الصواب انتهج منهجا آخر فقال إن الجواهر والأعراض متعلق الرؤية ولا محالة
أن بينهما اتفاقا وافتراقا فمتعلق الرؤية ومصححها إما ما به وقع الاتفاق
أو الافتراق أو هما معا لا جائز أن يكون المصحح
ما به الاتفاق
والافتراق معا أو الافتراق فقط إذ المصحح يكون في الجملة مختلفا والحكم
الواحد في المعقولات يستحيل أن تكون له علل مختلفة أو يكون المعلول أعم
منه فبقى أن يكون المصحح ما به الإتفاق فقط وما تخيل الاشتراك فيه بين
الجواهر والأعراض ليس إلا الوجود والحدوث لا غير والحدوث لا يصلح أن يكون
هو المصحح لتعلق الادراك بالشئ فإنه قد يدرك لا في حالة حدوثه كيف وأن بعض
الجواهر وبعض الإعراض حادثة عند الخصم و لا يتعلق بها الإدراك فيمتنع أن
يكون هو المصحح ثم إن معنى الحدوث ليس إلا كون الشئ موجودا بعد العدم أي
لم يكن فكان أو أنه ما لا يتم وجوده بنفسه وكل هذه سلوب واعدام لا سبيل
إلى القول بتعلق الإدراك بها فبقى أن يكون المصحح للإدراك إنما هو الوجود
فقط وواجب الوجود موجود فوجب القول بجواز تعلق الإدراك به
وهذا
الإسهاب أيضا مما لا يشفى غليلا إذ القول بأن الرؤية لا بد لها من مصحح
إما أن يراد به الفاعل أو القابل أو الغاية منه فلا معنى لحصره فيما
اختلفت فيه القوابل واتفقت بل جاز أن يكون الفاعل امرا خارجا وسواء كان
تأثيره وفعله بالطبع أو الارادة وعند ذلك فلا بد من أن يتبين تحقق مثله في
جانب تعلق الرؤية بواجب الوجود حتى يصح كيف وانه لا يصح ذلك بمجرد تحقق
الفاعل مع تعذر القابل ولهذا قالت الخصوم من الإلهيين إن العقل لنفوس
العالم علة فاعلية والمعلول متوقف على اعتدال المادة وتهيئها لقبوله فلا
بد مع الاشتراك في الفاعل من تحقق وجود القابل لا محالة ثم ولو قدر انحصار
الفاعل فيما وقع به الاختلاف والاتفاق في القوابل فلا يمتنع أن يكون
ما وقع به الافتراق له مدخل في التأثير والقول بأن الحكم الواحد
العقلى لا
يكون له علتان ولا يكون أعم من علته فيلزم عليه تعلق العلم بمتعلقاته
فإنها مختلفة من الواجب والجائز والمستحيل ولا محالة أنا لا نجد معنى
واحدا وقضية متحدة يقع بها الاشتراك بين هذه الأقسام الثلاثة فان كان لابد
وأن يكون الفاعل ما وقع به الاتفاق والافتراق بين القوابل فيلزم أن يكون
الفاعل ههنا مختلفا والمعلول متحدا لضرورة عدم الاشتراك في معنى واحدا كما
بيناه
ثم إن المعلول إنما يكون أعم من العلة عند القول بتعددها أن
لو كان المعلول في نفسه واحدا لا تكثر فيه أما إذا كان متعددا بتعدد محاله
ومتعلقاته فلا إذ لا مانع من ان يكون كل واحد من العلتين المختلفتين يؤثر
في أحد المعلولين دون الآخر ولا يترتب معلول كل واحد على العلة الأخرى كيف
وأن هذا القائل ممن يجوز صدور المختلفات عن الواحد فما بال الواحد مما
يمتنع صدوره عن المختلفات وما الذى يمكن أن يتخيل فارقا بين الصورتين
وقادحا بي الحالتين
ثم إن هذا القائل إن كان ممن يعترف بأن الوجود
هو نفس الموجود وأنه ليس بزائد على ذات الموجود فلا محالة أن الذوات
مختلفة ولا محيص من الاعتراف بكون المخصص مختلفا وعند ذلك فلا يلزم من
جواز تعلق الرؤية بأحد المختلفين جواز تعلقها بالآخر وان كان ممن يقول
بكونه زائدا على ذات الموجود فإما أن يكون قضية مطلقة مشتركة أو أن يكون
له تخصيص بكل واحد من الذوات فإن كان الأول فمحال أن يتعلق
به
الإدراك وان كان الثانى فلا خلاف في تغايره وإذ ذاك فلا بد من الاختلاف
بين هذه الحودث في امر زائد على نفس الوجود والا لما صح القول بالتغاير
وعند ذلك فإما أن يكون الوجود متعلق الرؤية أو مصححا لها مع قطع النظر عن
المخصص فهو ممتنع وإما أن لا يكون مصححا إلا بالنظر إلى المخصص فلا مانع
من جعل المخصص من جملة المصحح ولا مهرب منه هذا ان أريد به الفاعل
وإن أريد به القابل فالقابل لما اتحدت حقيقته لا يجب أن يكون هو في نفسه
متحدا كما في تعلق العلم بمتعلقاته ثم إنه لا خلاف في جواز تعدد المقبول
واتحاد القابل إذ الشئ الواحد قد يكون قابلا للكمية والكيفية والإضافة
وغير ذلك من الأغراض مع اختلافها وإذا لم يبعد اتحاد القابل لم يبعد اتحاد
المقبول وتعدد القابل أيضا ثم إنه إما أن يكون وجود الموجود الذى هو
المصحح هو نفس الوجود أو زائدا عليه وعلى كلا التقديرين فيلزم التعدد في
المصحح كما سلف
وإن أريد بالمصحح الغاية فهو إن سومح فيه فلا معنى
لحصره فيما وقع به الاتفاق والافتراق في القابل أيضا ثم يلزم عليه تعلق
العلم بمتعلقاته كما أسلفناه ولا محيص عنه وإن أريد به ما هو كالذاتى فلا
يخفى أن قول القائل ما وقع به الاتفاق والافتراق بين متعلقات الإدراك يكون
ذاتيا لنفس الإدراك تضليل وحيد عن واضح السبيل كيف ويلزم عليه أيضا تعلق
العلم بمتعلقاته كما سلف
ثم لو سلم أن ما وقع به الافتراق لا يصلح
أن يكون مصححا فإن المصحح لا بد وأن يكون أمرا مشتركا فلا بد من بيان أنه
لا مشترك إلا الوجود والا فمع جواز القول باشتراكهما في معنى آخر غير
الوجود فيجوز أن يكون هو المصحح أو داخلا في المصحح
وعند ذلك فلا
يلزم جواز تعلق الرؤية بواجب الوجود لجواز أن يكون المصحح غير شامل له كما
في الوجود وذلك لا دليل عليه غير البحث والسبر وهو ما لا يرقى إلى ذروة
اليقين بل لعله مما يقصر عن إفادة الظن والتخمين
كيف وأن ما سلم
الخصم تعلق الرؤية به شاهدا ليس إلا الأجرام أو ما قام بها دون الجواهر
التى عنها تكون الأجرام بل أخص من ذلك فإنه لا يسلم تعلق الرؤية بكل جرم
وكل عرض بل بعضها مما لا تتعلق الرؤية عنده به كما في الهواء والطعوم
والأراييح ونحوه وإذا لم تتعلق الرؤية بغير الأجرام والأكوان فلا محالة أن
الاجرام عند أهل الحق هى كل ما ائتلف من جوهرين فصاعدا ومع قطع النظر عن
التأليف فالقول بتفهم معنى الجرم محال والتأليف لا محالة عرض وبينه وبين
الأعراض مجانسة ما واشتراك في معنى ما وعند ذلك فلا مانع من أن يكون
المصحح للرؤية هو ذلك المعنى ومع القول به فلا سببيل إلى تعلق الرؤية
بواجب الوجود لعدم مشاركته لغيره من المرئيات في ذلك المعنى
ثم إنه
لو قدر أنه لا مشترك إلا الوجود فلا بد من بيان أن وجود واجب الوجود مجانس
للوجود الذى هو متعلق الرؤية شاهدا حتى يلزم تعلق الرؤية به وذلك مما يعز
ويشق جدا
ومما اعتمد عليه أيضا أن قيل الرؤية معنى لا يتأثر به
المرئى ولا يتأثر منه لا بأفعال ولا بانفعال وما هذا حكمه في تعلقه فلا
مانع من تعلقة وصار حكمه حكم العلم من غير فرق
واعلم أن هذه الطريقة
مع احتاجها إلى تقرير معنى التأثير وحصر الموانع بأسرها ونفيها مما لا
حالصل لها وذلك أنه لا يخفى ان تعلق الشئ بغيره ليس مما يتم بانتفاء
التأثير وزوال المانع بل لابد من بيان الصلاحية للتعلق بين المتعلقين ولو
انتفى كل ما يقدر من الموانع وعند العود إلى بيان الصلاحية والقبولية يرجع
الكلام إلى الوجود وتصحيحة للتعلق وقد انتهى القول فيه
فإذا التحقيق
في إيضاح الطريق يتوقف على بيان معنى الإدراك والكشف عن حقيقته فنقول
الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف على ما يخيل في النفس من الشئ
المعلوم من جهة التعقل بالبرهان أو الخبر ولهذا نجد التفرقة بين كون
الصورة معلومة للنفس مع قطع النظر عن تعلق الحاسة الظاهرة بها وبين كونها
معلومة مع تعلق الحاسة بها فإذا هذا الكمال الزائد على ما حصل في النفس
بكل واحدة من الحواس هو المسمى إدراكا كما مضى وقد بينا أن هذه الإدراكات
فيما مضى ليست بخروج شئ من الآلة الدراكة إلى الشئ المدرك ولا بانطباع
صورة المدرك فيها وانما هو معنى يخلقه الله تعالى في تلك الحاسة وقد بينا
أن البنية المخصوصة ليست بشرط له كما مضى بل لو خلق
الله ذلك
المعنى في القلب أو غيره من الأعضاء لقد كنا نسمى ذلك مدركا وإذا جاز أن
يخلق الله تعالى في الحاسة زيادة كشف وبيان بالنسبة إلى ما حصل في النفس
فلا محالة ان العقل لا يحيل أن يخلق الله تعالى للحاسة زيادة كشف وايضاح
بالنسبة إلى ما حصل في النفس من العلم به وأن تسمى تلك الزيادة من الكشف
إدراكا والجاحد لذلك خارج عن العدل والانصاف منتهج منهج الزيغ والإنحراف
ومن عرف سر هذا الكلام عرف غور كلام أبى الحسن في قوله إن الإدراك نوع
مخصوص من العلوم لكنه لا يتعلق إلا بالموجودات وإذا عرف ذلك فالعقل يجوز
أن يخلق الله تعالى في الحاسة المبصرة بل وفى غيرها زيادة كشف بذاته
وبصفاته على ما حصل منه بالعلم القائم في النفس من غير أن يوجب حدوثا ولا
نقصا وذلك هو الذى سماه أهل الحق إدراكا
فالمنازعة إذا بعد تحقيق هذا المعنى وإيضاحه إما أن تستند إلى فساد في
المزاج أو إلى محض الجحد والعناد
وعلى هذا نقول يجوز أن يتعلق بالإدراك والطعوم والأراييح والعلوم والقدر
والإرادات وغير ذلك مما لا تتعلق به الإدراكات في مجارى العادات وبما
حققناه يندفع ما يهول به الخصوم ويعتمدون عليه ويستندون في الإلزام اليه
وهو قولهم إن الرؤية تستدعى
المقابلة والمقابة تستدعى الجهة
والجهة توجب كونه جوهرا أو عرضا فإنهم لم يبنوا ذلك إلا على فاسد أصولهم
في أن الأدراك بالبصر لا يكون إلا بانبعاث الأشعة من العين واتصالها
بالمبصر أو انطباع المبصر في البصر بسبب المقابلة وتوسط المشف وذلك كله قد
ابطلناه وبينا أنه ليس الإدراك إلى نوعا من العلوم يخلقه الله تعالى في
البصر وذلك لا يوجب في تعلقه بالمدرك مقابلة ولا جهة أصلا كيف وأن هذا لا
يسوغ من المعترف من الخصوم بكون البارى تعالى يرى نفسه وغيره والا كان
البارى تعإلى في جهة ولكان الإزام عليه منعكسا
ومن الاصحاب من أورد
في دفع ذلك رؤية الإنسان نفسه في المرآة وان لم يكن في مقابلة نفسه لكن
فيه نظر وهو مما لا يكاد يقوى وللخصوم على ما ذكرناه خيالان
الخيال
الأول أنهم قالوا ما ذكرتموه في إدراك البصر اما تعممونه بكل الإدراكات أو
توجبون تخصيصه بالبصر فقط فان قلتم بالتعميم فيلزمكم على سياقه أن يكون
البارى مسموعا ومشموما ومذاقا وملموسا وذلك مما يتحاشى عن القول به ارباب
العقول وان قلتم بالتخصيص فلا بد من وجه الافترق بينه وبين باقى الإدراكات
والا فهو تحكم غير معقول
الخيال الثانى
أنهم قالوا لو جاز
أن يكون مرئيا على النحو الذى حققتموه لجاز أن يكون مرئيا في دار الدنيا
في وقتنا هذا إذ الموانع من القرب المفرط والبعد المفرط والحجب منفية فحيث
لم ينفع انتفاء الموانع لم يكن ذلك إلا لكونه غير مرئى في نفسه
قلنا
أما الخيال الأول فقد قال بعض الأصحاب إنه إنما لم يجز تعلق باقى
الإدراكات به من جهة أن شرط حصول الإدراك بها اتصال الإجسام ومحاذاة
الأجرام ولا كذلك البصر وهو مما لا يكاد يفيد إذ الشغب فيه غير منقطع
واللجاج غير منحسم ولعل الخصم قد يقابل بمثل ذلك في البصر ودفعه عسير غير
يسير
فالحق في ذلك أن يقال إن كل الإدراكات من جهة كونها كمالات
يحصل بها مزيد كشف المدرك بالنسبة إلى ما تعلق به من العلم النفسانى وأنها
مخلوقة لله تعإلى في محال الإدراك من غير تأثير في المدرك والمدرك
والاتصال والانفصال فغير مختلفة وإنما الاختلاف فيها من جهات أخر وذلك أن
ما يخلقه الله من زيادة الكشف إن كان من ذات الشئ ووجوده بالنسبة إلى ما
يحصل من تعلق علم النفس به شرحا سمى ذلك نظرا وان تعلق العلم بكونه كلاما
كان ذلك من الكلام النفسانى او اللسانى مما يحصل بخلق الله تعالى من زيادة
الكشف بكونه كلاما لا من جهة كونه موجودا سمى ذلك سماعا وبهذا المعنى سمى
موسى سامعا لكلام الله تعالى وما يحصل بخلق الله
تعالى من زيادة
الكشف بطعم شئ على ما حصل من العلم به لا من جهة كونه موجودا أو كلاما سمى
ذلك الإدراك ذوقا وعلى هذا النحو فيما يدرك من الكيفيات المحسوسة الأربعة
أو الملموسات
ولا محالة أن هذه الإدراكات مختلفة النوعية متمايزة
بالخواص فإن ما حصل من الكشف والزيادة من كون الموجود موجودا امر يغاير
بذاته ما حصل من مزيد الكشف من كونه كلاما أو طعما أو رائحة أو غيره
فامتناع كون البارى مسموعا انما كان من جهة أنه ليس هو في نفسه كلاما ولا
حقيقته نطقا فالعلم لم يتعلق به بكونه كلاما فادراكه إذ ذاك بالسمع يكون
ممتنعا بلى لو قيل إن كلامه يكون مسموعا لقد كان ذلك جائزا وعلى هذا النحو
امتناع كونه مشموما ومذوقا وملموسا ولا كذلك البصر فإن البصر هو ما يخلقه
الله من زيادة الكشف من كونه ذاتا ووجودا وذلك مما لا يستحيل تعلق العلم
به حتى لا يسمى ما حصل من مزيد الكشف عيله بصرا ومن عرف ما نعنى بإدراك
هان عليه الفرق وسهل لديه فهم معنى الرؤية واندفع عنه الاشكال وزال عن
ذهنه الخيال
وعلى هذا حصول مثل هذه الإدراكات لله تعالى واتصافه بها
غير ممتنع في نفسه عقلا وان لم يجز القول بإطلاقها عليه شرعا لعدم وروده
بها فإن حصول الإدراكات المختلفة لمدرك واحد جائز أما تعلق الإدراكات
المختلفة بمدرك واحد من جهة واحدة فممتنع كما بينا واما انتفاء وقوع
الإدراك في وقتنا هذا فإنما يلزم منه انتفاء جواز تعلق الإدراك به أن لو
لم يقدر ثم مانع وصاد وليس مستندهم في حصر ما ذكروه من الموانع غير البحث
والسبر وأعلى درجاته أن يفيد ظنا بعدم المانع لا علما كيف وأنه من المحتمل
أن يكون المانع من الإدراك تكدر النفس بالشواغل البدنية وانغماسها في
الرذائل الشهوانية وتعلقها بعالم الظلال وانهماكها في البدن وما يتعلق به
من الأحوال فعند صفوها في الدار
الأخرى وزوال كدورتها بانقطاع علائقها وانفصال عوائقها يتحقق
لها ما كانت مستعدة لقبوله ومتهيئة لإدراكه
ولا يهولنك ما يجعجع به الخصم ويشنع وهو قوله لو جاز أن يكون مدركا لا
متنع أن لا يتعلق به الإدراك مع سلامة آلة الإدراك والا جاز أن يكون
الإنسان بين يديه فيل واقف أو جبل شامخ وهو لا يراه
فذلك من السفسطة
والتجاهل لأنه لما وقع الاشتراك في اسم الجواز بين الجواز العقلى والعادى
ورأى ان من حكم بذلك كان بالنظر إلى العادة مستقيما ظن ذلك واقعا في
القطعى أيضا وليس كذلك على ما سبق تحقيقه ثم وكيف ننكر ذلك مع ما قد ورد
من الأخبار وتواتر من الآثار المستندة إلى الشريعة الطاهرة والرسالة
الظاهرة مما أوجب لنا العلم بان محمدا صلى الله عليه كان يرى جبريل ويسمع
كلامه عند نزوله عليه ومن هو حاضر في مجلسه لا يدرك شيئا من ذلك مع سلامة
آلة الإدراك
ومما يلزم المعترف بالنبوات المصدق بالرسالات في جواز تعلق الإدراك
بالبارى
تعالى قول الكليم ارنى أنظر إليك ولو كان مستحيلا لكان الكليم
الأمين على
الرسالة المصطفى للنبوة جاهلا بالله ومما يكون لو كان عليه لجاز أن يعتقده
جسما أو عرضا أو غير ذلك وذلك مما تأباه العقول ومراتب الإمامة حيث اعتقد
بالله ما لا يليق به وذلك كفر ولا يلزم عليه عدم معرفته لوقوع الرؤية في
الدنيا فان الظن بذلك أو الجهل به لا يعد كفرا
وقوله تبت إليك مما
لا ينهض شبة في جواز خطئه وجهله بذلك إذ التوبة قد تطلق بمعنى الرجوع ومنه
قوله تاب عليهم ليتوبوا أى رجع عليهم بالفضل والإنعام وعند ذلك فيحتمل أنه
أراد بالتوبة أن لا يرجع إلى مثل تلك المسألة لما رأى من الأهوال لا لكونه
غير جائز في نفسه ويحتمل أنه لما رأى تلك الأهوال تذكر له ذنبا فأقلع عنه
بالتوبة لا لأن ما سأل عنه ليس جائزا في نفسه ولا يمكن حمل السؤال على طلب
مثل ذلك الجواب لأجل دفع توقعهم في قولهم أرنا الله جهرة ولا على العلم
بالله والمعرفة به فانه كيف يظن بالنبى سؤال المحال لأجل قومه بل لو علم
أن ذلك مما لا يجوز لبادر إلى دفعهم في الحال كما قال لهم إنكم قوم تجهلون
عند
قولهم اجعل لنا إلها كيف وقد وقع ردعهم وزجرهم عن مثل ذلك
السؤال بأخذ الصاعقة لهم والعذاب الأليم عقيبه كما قال تعالى فأخذتهم
الصاعقة وهو ينظرون وليس في أخذ الصاعقة لهم ما يدل على امتناع ما طلبوه
بل لأنهم طلبوا ذلك في معرض التشكيك في نبوة موسى وقصدوا إعجازه عن ذلك
فأنكر الله ذلك منهم كما انكر قولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض
ينبوعا وقولهم أنزل علينا كتابا من السماء لا لأن ذلك مستحيل بل بالنظر
إلى ما قصد بالسؤال ههنا ثم الآية بظاهرها تدل على أن السؤال لم يكن إلا
لموسى عليه السلام بقوله أرنى وقوله تعالى لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل
فإن استقر مكانه فسوف ترانى ولو كان المقصود من ذلك دفع قومه عن سؤال
الرؤية لم ينتهض دفع موسى عن الرؤية شبهة في دفع قومه
وأما حمل
الطلب على المعرفة بالله فأبعد من الأول أيضا من جهة أن لفظ النظر إذا
أطلق فالمفهوم منه ظاهرا ليس إلا النظر بالعين ثم إن موسى عليه السلام لم
يكن جاهلا بربه ولا غير عارف به وإلا لما صح كونه نبيا فحمل الرؤية على
التعريف لما قد عرفه يكون من عبث الكلام وسمجه ولا يجوز أن ينسب مثل ذلك
إلى جاهل غبى فضلا عن نبى صفى
لكن قد يتخيل من لن ترانى ما يدرأ
القول بالجواز وهو بعيد فإنا سنبين أن ذلك لم يكن منعا له إلا في الدنيا
وان قيل إن ذلك للتأبيد فليس منه ما يدل على نفى
الجواز بل لو
قيل إنه يدل على الجواز لقد كان ذلك سائغا واقعا من جهة انه لم يقل لست
بمرئ بل احال ذلك على عجز الرائى وضعفه عن الإدراك بقوله لن ترانى ولو كان
غير مرئى لكان الجواب لست بمرئى كما لو قال أرنى أنظر إلى صورتك ومكانك
فإنه لا يحسن أن يقال لن ترى صورتى ولا مكانى بل لست بذى صورة ولا مكان
وعلى الجملة فلسنا نعتمد في هذه المسألة على غير المسلك العقلى الذى
اوضحناه إذ ما سواه لا يخرج عن الظواهر السمعية والاستبصارات العقلية وهى
مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين فلا يذكر إلا على سبيل التقريب
واستدراج قانع بها إلى الإعتقاد الحقيقى إذ رب شخص يكون انقياده إلى ظواهر
الكتاب والسنة واتفاق الأمة اتم من انقياده الى المسالك العقلية والطرق
اليقينية لخشونة معركها وقصوره عن مدركها
وإذا عرف جواز الرؤية عقلا
فيدل على وقوعها شرعا قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجه
الاحتجاج منه أن النظر في لغة العرب قد يطلق بمعنى
الانتظار ومنه
قوله تعإلى انظرونا ان انتظرونا وقوله ما ينظرون إلا صيحة واحدة أي
ينتظرون ومنه قول الشاعر ... فإن يك صدر هذا اليوم ولى ... فإن غد لناظره
قريب ...
أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد
يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال
نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة
وإذا استعمل بازائه وصل باللام ومنه تقول العرب نظر فلان لفلان وقد يطلق
بمعنى الإبصار بالبصر وإذا استعمل بإزائه وصل بإلى ومنه قول الشاعر ...
إنى إليك لما وعدت لناظر ... نظر الذليل إلى العزيز القاهر ...
ومقال العرب نظرت إلى فلان أى أبصرته ببصرى
والنظر المذكور في الآية موصول بإلى فوجب حمله لغة على النظر بالعين فإن
قيل قد يوصل النظر بإلى ولا يراد به الإبصار بالعين ومنه قول الشاعر ...
ويوم بذى قار رأيت وجوهم ... إلى الموت من وقع السيوف نواظرا
والموت لا يتصور ان يكون مرئيا بالعين ثم إنه يحتمل أن يكون
المراد بقوله
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة أى إلى ثواب ربها ناظرة ويكون ذلك تجوزا
بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كيف وهى معارضة بقوله تعالى لا
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقوله لموسى لن ترانى وهى للتأبيد وليس
العمل بأحد الظاهرين بأولى من الآخر بل الترجيح لنا فإنه أورد ذلك في معرض
التمدح والاستعلاء فلو جاز أن يكون مدركا لزال عنه التمدح وهو محال
قلنا قد بينا أنه مهما اتصلت إلى بالنظر فإنه لا يراد به غير النظر بالعين
هو المراد من قول الشاعر ... إلى الموت من وقع السيوف نواظرا ...
لكن يحتمل أنه أراد بالموت الكر والفر والطعن والضرب معبرا باسم المسبب عن
السبب ويحتمل أنه أراد به أهل الحرب الذين يجرى الموت والقتل على أيديهم
ولهذا قال الشاعر ... أنا الموت الذى خبرت عنه ... فليس لهارب منى نجاء
...
وأما نسبة النظر إلى الثواب فمع مخالفته الظاهر فيمتنع حمله
عليه فإن ذلك إنما ورد في معرض الامتنان والإنعام والنظر إلى الثواب ليس
بثواب ولا إنعام فيكون فيه إبطال فائدة الانعام وهو ممتنع
اما قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فيحتمل أنه اراد به الإدراك الذى يتبادر إلى الأفهام ويغلب على الأوهام من الإحاطة بالغايات والتحديد بالنهايات دفعا لوهم من يتوهم أنه يرى لصورة أو شكل مخصوص ويحتمل أنه أراد بذلك في دار الدينا ويكون المراد من ذلك اللفظ العام المعنى الخاص كما في قوله الله خالق كل شئ وقوله ما تذر من شئ أتت عليه الا جعلته كالرميم إلى غير ذلك من الآيات والظواهر السمعيات وأما وجه التمدح فليس إلا في قوله يدرك الأبصار لا في قوله لا تدركه الأبصار ولا يمكن حمله على كلا القسمين فان بعض الموجودات عند الخصم لا يدرك بالأبصار وليست ممدوحة بذلك وامتداحه لنفسه فيما وقع به الاشتراك بينه وبين ما ليس بممدوح محال كما إذا قال أنا موجود أو ذات كيف لا وإن الخصم لا يمكنه التمسك بهذه الآية فان ما ثبت للبارى تعالى يجب أن يكون نفس ما نفى عن غيره وما ثبت للبارى عند الخصم ليس إلا نفس العلم بالأبصار لا أمرا زائدا عليه فالمنفى عن الأبصار يجب أن يكون نفس العلم وليس ذلك حجة في نفى الإدراك الذى هو زائد على العلم
وقوله لموسى عليه السلام لن ترانى فيحتمل أنه أراد ذلك في دار
الدنيا لا
في العقبى وهو الأولى لآن يكون الجواب مطابقا للسؤال وهو لم يسأل الرؤية
في غير الدنيا
ولن فقد قيل المراد بها التأكيد لا التأبيد وإذ ذاك
فالتخصيص جائز كما مضى وإن قدر أن ذلك متأبد في حق موسى عليه السلام فليس
ذلك حجة في نفى الرؤية بالنسبة إلى غيره مطلقا والقول بتأويل هذه الظواهر
على ما ذكرناه أولى عملا بالظاهر من الجانبين وجمعا بين الدليلين وذلك لا
ينعكس في تأويل ما اعتمدنا عليه فإن ذلك لا يقع الا بصرفه الى ما لا يعهد
بالأجماع إطلاقه عليه وبإبطال فائدة الإنعام وكلاهما بعيدان ولا كذلك ما
ذكرناه من التأويل إذ قد عهد مثله في الأدلة السمعية والظواهر الشرعية
غالبا وهذا غاية ما يعتمد عليه في طرف الوقوع ومن رام اليقين فيه إيجابا
أو سلبا فقد كلف نفسه حرجا
والله الموفق للرشاد
القاعدة الثانية
في ابطال التشبيه وبيان ما لا يجوز على الله تعالىمعتقد اهل الحق ان البارى لا يشبه شيئا من الحادثات ولا يماثله شئ من الكائنات بل هو بذاته منفرد عن جميع المخلوقات وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا تحله الكائنات ولا تمازجه الحادثات ولا له مكان يحويه ولا زمان هو فيه اول لا قبل له وآخر لا بعد له ليس كمثله شئ وهو السميع البصير
وأما اختلاف مذهب أهل التشبيه فقد قالت الفلاسفة إنه جوهر بسيط لا تركيب فيه بوجه من الوجوه ولم يتحاشوا من إطلاق اسم الجوهر عليه وفسروا الجوهر بأنه الموجود لا فى موضوع والموضوع هو المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه ولربما تحاشى بعض الحذاق منهم عن إطلاق اسم الجوهر عليه وزعم أنه الذى ما هيته إذا وجدت كانت لا فى موضوع والبارى تعالى ليس وجوده زائدا على ماهيته بل ذاته وجوده ووجوده ذاته فلم يوجد فيه معنى الجوهر
وأما
الكرامية فمنهم من قال إنه جسم ومن أهل الاهواء من بالغ وقال إنه صورة على
صورة الإنسان ثم هؤلاء اختلفوا فمنهم من قال على صورة شاب أمرد جعد قطط
ومنهم من قال هو على صورة شيخ أشمط الرأس واللحية ومنهم من قال إنه مركب
من لحم ودم
واتفقت الكرامية على أن البارى تعالى محل للحوادث لكنهم
لم يجوزوا قيام كل حادث بذاته بل ما يفتقر إليه من الإيجاد والخلق ثم
هؤلاء يختلفون في هذا الحادث فمنهم من قال قوله كن ومنهم من قال هو
الإرادة وخلق الإرادة أو القول في ذاته يستند إلى القدرة القديمة لا انه
حادث بإحداث وأما خلق سائر المخلوقات فإنه مستند إلى الإرادة أو القول على
نحو اختلافهم فالمخلوق القائم بذاته يعبرون عنه بالحادث والمباين لذاته
يعبرون عنه بالمحدث وقد أطبق هؤلاء على أن ما قام بذاته من الصفات الحادثة
لا يتجدد له منها اسم ولا يعود إليه منها حكم حتى لا يقال إنه قائل بقول
ولا مريد بإرادة بل قائل بالقائلية مريد بالمريدية وهى المشيئة الأزلية
فعلى هذا ما حدث وهو مباين لذاته يسمى محدثا بإحداث وما حدث في ذاته من
الصفات تسمى حادثة لا بإحداث بل بالمشيئة القديمة
وقد اتفتق هؤلاء
بأسرهم مع بعض الحشوية على أن البارى تعالى في جهة وخصوها بجهة فوق دون
غيرها من الجهات لكن اختلفوا في الجهة فقالت الكرامية إن كونه في الجهة
كون الأجسام وقالت الحشوية في الجهة ليس ككون شئ من الحادثات فهذه تفاصيل
مذاهب أهل الاهواء وتشعبها في التشبيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا
ونحن الآن مشمرون للكشف عن زيف مآخذهم وإبطال مذاهبهم
وقد سلك بعض الأصحاب في الرد على هؤلاء طريقا شاملا فقال لو كان البارى
مقدرا بقدر مصورا بصورة متناهيا بحد ونهاية مختصا بجهة متغيرا بصفة حادثة
في ذاته لكان محدثا إذ العقل الصريح يقضى بأن المقادير في تجويز العقل
متساوية فما من مقدار وشكل يقدر في العقل إلا ويجوز أن يكون مخصوصا بغيره
فاختصاصه بما اختص به من مقدار أو شكل أو غيره يستدعى مخصصا ولو استدعى
مخصصا لكان البارى تعالى حادثا
ولكن هذا المسلك مما لا يقوى وذلك
أنه وإن سلم أن ما يفرض من المقادير والجهات وغيرها ممكنة في أنفسها وأن
ما وقع منها لا بد له من مخصص لكن انما يلزم أن يكون البارى حادثا أن لو
كان المخصص خارجا عن ذاته ونفسه ولعل صاحب هذه المقالة لا يقول به وعند
ذلك فلا يلزم أن يكون البارى حادثا ولا محتاجا إلى غيره أصلا
فإن
قيل إن ما اقتصاه بذاته ليس هو بأولى من غيره لتساوى الجميع بالنسبة إليه
من جهة الاقتضاء فهو محز التخيلات ولعل الخصم قد لا يسلم تساوى النسبة من
جهة الاقتضاء إلا أن يقدر انه لا اختلاف بين هذه الممكنات ولا محالة أن
بيان ذلك متعذر جدا كيف وأنه يحتمل أن ينتهج الخصم فى تخصيص هذه
الصفات الثابتة للذات منهج أهل الحق في تخصيص سائر الممكنات وبه
درء الإلزام فإذا الواجب التفصيل في إبطال مذاهب أهل الضلال
وأول مبدوء به إبطال القول بكونه جوهرا فنقول
لو كان جوهرا لم يخل إما ان يكون واجبا بذاته أو ممكنا أو ممتنعا لا جائز
أن يكون ممتنعا وإلا لما وجد ولا جائز أن يكون ممكنا وإلا لافتقر إلى مرجح
خارج عن ذاته وهو ممتنع كما سلف ولا جائز ان يكون واجبا لذاته وإلا لكان
كل جوهر واجبا لذاته إذ حقيقة الجوهر من حيث هو جوهر لا تختلف وهذه
المحالات انما لزمت من فرض كون البارى تعالى جوهرا فليس بجوهر فإن ما ليس
لا يلزم من فرضه محال
فإن قيل المعنى بكونه جوهرا ليس إلا أن وجوده
لا فى موضوع وهذا القدر إما أن يكون ممنوعا أو مسلما فإن كان ممنوعا فقد
أوجبتم افتقار واجب الوجود إلى غيره وهو ممتنع وإن كان مسلما فهو المقصود
وأما قولكم إنه لو كان واجبا لكان كل جوهر واجبا للزوم الاشتراك في حقيقة
الجوهرية فإنما يلزم أن لو لزم الاشتراك في حقيقة الجوهرية وما المانع من
أن يكون جوهرا لا كالجواهر كما أنه ذات لا كالذوات ثم وإن سلم أن الاشتراك
في حقيقة الجهورية واقع فيلزمكم مثله في سائر الموجودات لمشاركتها له في
الوجود والذات فإن قلتم لم يكن واجبا من حيث هو موجود ولا من حيث هو ذات
بل من حيث هو ذات مخصوصة ووجود مخصوص فاقبلوا منا مثله ههنا وهو أنه لم
يكن واجبا من حيث هو جوهر مطلقا بل من جهة كونه جوهرا مخصوصا
والجواب أن ما قيل من أن البارى جوهر يعنى أن وجوده لا في موضوع
فان أريد
بمدلول اسم الجوهر سلب الموضوع عنه فقط فذلك مما لا سبيل إلى انكاره من
جهة المعنى وإن كان إطلاقه من جهة الشرع والوضع خطأ وانما محز الإشكال
وموضع الخيال دعوى تخصيص سلب الموضوع بحقيقة الجوهر وجعل البارى تعالى
جوهرا على النحو الموسوم من إطلاق لفظ الجوهر ولا محالة أن دعوى ذلك مما
يقود إلى الإلزام الذى ذكرناه ويسوق إلى المحال الذى أسلفناه
وما
قيل من أنه جوهر لا كالجواهر فتسليم للمطلوب من جهة المعنى وانا لا ننكر
كونه موجودا وحقيقة لا كالحقائق وانما ننكر كونه مشابها لها وعند ذلك
فحاصر الخلاف انما يرجع إلى مجرد إطلاق الأسماء ولا مشاحة فيها الا من جهة
ورود التعبير بها وأما ما ذكروه من الإلزام فإنما يتجه أن لو كان غير
البارى تعالى مثليا من جهة ما وليس كذلك بل الاشتراك ليس الا في التسمية
بكون كل واحد منهما ذاتا ووجودا ومجرد الاشتراك في التسمية لا يوجب
الاشتراك بينهما فيما يثبت لأحدهما وهذا بخلاف الجواهر فإنها من حيث هى
جواهر متماثلة فما ثبت لواحد منها ثبت لما هو مماثل له أيضا
فإن
قيل مثله فيما نحن فيه ولم يثبتوا لواجب الوجود من الحوادث مثلا فقد تركوا
مذهبهم وعاد الخلاف إلى مجرد التسمية ومطلق العبارة والخطب فيه يسير كما
مضى
وأيضا فإنه لو كان جوهر لم يكن القول بكونه مرجحا لغيره من الجواهر بأولى
من العكس إذ لا أولوية لأحدهما لتحقق المماثلة بينهما
فإن قيل إنه مرجح لا من حيث هو جوهر بل من جهة ما اختص به من الصفات عن
غيره
قلنا ما اختص به من الصفات اما داخلة في ذاته او خارجة لازمة فان كانت
داخلة في ذاته فمن حيث ذاته لم يخالف غيره من الجواهر فإذا لا اختصاص ثم
يلزمهم القول بتركب ذات واجب الوجود ولا محيص عنه وان كانت خارجة عن ذاته
ملازمة له فهى مفتقرة إليه في وجودها والمفتقر إلى الشئ لا يصلح أن يقوم
ما هو من نوع ذلك الشئ
فان قيل ما ذكرتموه لازم على أصلكم أيضا حيث
اعتقدتم أن تخصيص الحدوث بإرادته والوجود بقدرته وهذه الصفات إما أن تكون
داخلة في ذاته فيلزم أن يكون مركبا وان كانت خارجة لازمة فهى عرضية
والأعراض كيف تقوم الجواهر في وجودها وجنسها مفتقر إلى جنسها
قلنا
انقلاب هذا الإلزام مما لا يوجب على ما نعتقده مناقضة ولا إفحاما فأما لو
سلكنا اعتقاد كونها داخلة في مدلول اسم البارى فهو نفس ما اعتقدناه وعين
ما حققناه
وسواء قلنا إنها معتددة أو متحدة كما مضى وان سلكنا
كونها خارجة عن مدلول اسمه وذاته فذلك أيضا مما لا يوجب محالا على أصلنا
فإنا وان قلنا إنها مفتقرة إليه على نحو افتقار الأعراض إلى ما تقوم به
فلا نعتقد أن ذاته والمقوم لما قام بها جوهر حتى يلزمنا المحال لحكمنا
بافتقار الجوهر في إيجاده إلى ما لا يتم وجوده إلا مفتقرا إلى ما هو من
جنس الجوهر بل المعتقد أن ما قامت به هذه الصفات ليس من جنس ما هو مفتقر
اليها وإذ ذاك فالإشكال مندفع عنا
وإذا ثبت أنه ليس بجوهر لزم ألا
يكون جسما فإنه مهما انتفى أعم الشيئين لزم انتفاء الأخص قطعا مع أن ما
ذكرناه من المسالك في نفى الجوهرية وما يلزم عليها ووجوه الانفصال عنها
يمكن إجراؤها بعينها ههنا
فإن قيل ما نشاهده من الموجودات ليس إلا
أجساما واعراضا وإثبات قسم ثالث مما لا نعقله وإذا كانت الموجودات منحصرة
فيما ذكرناه فلا جائز أن يكون البارى عرضا لأن العرض مفتقر إلى الجسم
والبارى لا يفتقر إلى شئ والا كان المفتقر إليه أشرف منه وهو محال وإذا
بطل أن يكون عرضا بقى أن يكون جسما
قلنا منشأ الخبط ههنا انما هو من
الوهم باعطاء الغائب حكم الشاهد والحكم على غيرالمحسوس بما حكم به على
المحسوس وهو كاذب غير صادق فان الوهم قد
يرتمى إلى أنه لا جسم
إلا في مكان بناء على الشاهد وإن شهد العقل بأن العالم لا في مكان لكون
البرهان قد دل على نهايته بل وقد يشتد وهم بعض الناس بحيث يقضى به على
العقل وذلك كمن ينفر عن المبيت في بيت فيه ميت لتوهمه أنه يتحرك أو يقوم
وان كان عقله يقضى بانتقاء ذلك فإذا اللبيب من ترك الوهم جانبا ولم يتخذ
غير البرهان والدليل صاحبا وإذا عرف أن مستند ذلك ليس إلا مجرد الوهم
فطريق كشف الخيال إنما هو بالنظر في البرهان فإنا قد بينا أنه لا بد من
موجود هو مبدأ الكائنات وبينا أنه لا جائز أن يكون له مثل من الموجودات
شاهدا ولا غائبا ومع تسليم هاتين القاعدتين يتبين أن ما يفضى به الوهم لا
حاصل له ثم ولو لزم أن يكون جسما كما في الشاهد للزم أن يكون حادثا كما في
الشاهد وهو ممتنع لما سبق
وليس هو أيضا عرضا وإلا لافتقر إلى مقوم
يقومه في وجوده إذ العرض لا معنى له إلا ما وجوده في موضوع وذلك أيضا محال
ولا يتطرق إليه العدم لا سابقا ولا لاحقا وإلا كان باعتبار ذاته ممكنا ولو
كان ممكنا لافتقر في وجوده إلى مرجح كما مضى
فإذا قد ثبت أن البارى تعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا محدث
بل أبدي لم يزل وسرمدى لا يزال وهو مع ذلك لا تحله الحادثات ولا
تقوم به الكائنات وللمتكلم في ذلك مسالك
المسلك الاول
هو انهم قالوا لو حجز قيام الحوادث بذات البارى تعالى لاستحال خلوه عنها وما استحال خلوه عن الحوادث فهو حادث والبارى مستحيل أن يكون حادثاواعلم أن هذا المسلك ضعيف جدا وذلك أنه وان تسومح بتسليم أن مالا يخلو عن الحوادث حادث لكن لا يلزم من كون البارى تعالى قابلا للحوادث أن لا يخلو عنها
فإن قيل إن ما قبل شيئا من الحوادث فهو قابل لضده وضد الحادث حادث ومهما كان قابلا لضده فهو لا يخلو عن أحدهما فلو كان البارى قابلا للارادة الحادثة لم يخل عنها أو عن ضدها ومهما لم يخل عن احدهما وهما حادثان لم يخل من الحوادث وكذا الكلام في القول الحادث أيضا
قلنا الغلط إنما نشأ من الجهل بمدلول لفظ الضد وعند الشكف عنه يتبين الحق من الباطل فنقول الضدان في اصطلاح المتكلم عبارة عما لا يجتمعان في شئ واحد من جهة واحدة وقد يكونان وجوديين كما في السواد والبياض وقد يكون أحدهما سلبا وعدما كما في الوجود والعدم فعلى هذا إن قيل للإرادة ضد فليس ضدها إلا عدمها وسلبها وكذا في القول أيضا والعدم المحض لا يوصف بكونه قديما ولا حادثا
ولا شاهدا ولا غائبا فإذا ليس كل ما هو ضد للحادث يكون
حادثا ثم ولو قدر أن ضد الإرادة والقول ليس إلا أمرا وجوديا فلا يلزم أن
يكون حادثا بمعنى ان وجوده بعد العدم لكونه ضده حادثا بل جاز أن يكون
قديما بمعنى أنه لا أول لوجوده لا بمعنى أن وجوده ليس بمعلول ويكون منشأ
وجوده نقضا لوجوده إلى عدمه وذلك المنشأ هو منشأ وجود ضده وهذا مما لا
يتقاصر عن قول أهل الحق إن منشأ عدم العالم في القدم إلى حين وجوده هو
منشأ وجوده في وقت وجوده
المسك الثانى
أنهم قالوا لو قامت بذاته صفة حادثة لا تصف بها وتعدى إليه حكمها وذلك كالعلم فإنه إذا قام بمحل وجب اتصافه بكونه عالما وكذا في سائر الأعراض القائمة بمحالها وسواء كان المحل قديما أو حادثا إد القول بالتفرقة بينهما محض جهالة ولبس فإنه لا فرق بين القديم والحادث فيما يرجع إلى كونه موصوفا قامت به صفة إلا فيما يرجع إلى الحدوث والقدم وذلك مما لا أثر له وإذا لزم عود حكم الصفة إليه بحيث يصح القول بكونه مريدا بإرادة وقائلا بقول فقد ثبت له ما لم يكن له أولا وذلك تغير وتبدل وإذا جاز عليه التغير استدعى مغير وذلك يفضى إلى كون البارى مفتقرا إلى غيره وهو متعذرقالوا ولا يلزم على ما ذكرناه الخلق فإنه غير قائم بذاته إذ لا فرق بينه وبين المخلوق
وهذا الطريق أيضا من النمط الأول في الفساد وذلك ان قائله وان كان ممن يقول
بالاحوال لكنه يعترف بكونها زائدة على الذات وحصول أمر زائد على
الذات
للذات مما لا يوجب افتقار الذات إلى غيرها وان كان ذلك الشئ الحاصل حادثا
نعم غاية ما يقدر افتقار الحاصل إلى مرجح والمرجح لا يستدعى أن يكون خارجا
عن لذات بل للخصم أن يقول المرجح إنما هو الذات بالقدرة والمشيئة الأزلية
كما كانت مرجحة الصفة الموجبة لهذا الحكم الحاصل وهذا مما لا محيص عنه إلا
بالتعرض إلى ابطال القول بكون الذات مرجحة بالقدرة والمشيئة بطريق آخر
وفيه خروج عن خصوص هذا الطريق إلى ما هو مستقل بإفادة المقصود
فإن
قيل إذا صلح أن تكون ذات واجب الوجود مرجحة بالقدرة والمشيئة جاز أن تجعل
مرجحة لكل محدث إذ لا فرق بين الحادث والمحدث من حيث أنه لم يكن فكان وإن
افترق من حيث أن احدهما صفة والآخر خارج وذلك مما لا يثير خيالا وإذا صلح
أن يكون المرجح للمحدثات القدرة القديمة والمشيئة الأزلية فلا حاجة إلى
الحادث الذى هو القول والإرادة
قلنا وهذا ايضا مما لا يثير غبارا
على وجه الكلام وذلك أنه وإن قدر صلاحيته لإحداث المحدثات فلا يلزم أن لا
يضاف إليه إحداث صفة في ذاته من كونه صاحا أن يحدث المحدثات وليس هذا في
ضرب المثال الا كما لو قال القائل إنه إذا كان صالحا لإيجاد الإنسان ينبغى
إلا يكون موجدا للفرس ولا يخفى ما فيه من الركاكة والشناعة
وما قيل
من أنه لا فائدة في إيجاده فمتهافت فم تهافت أيضا فإنه مع ما فيه من
الركاكة ومحض الدعوى والقول بوجوب رعاية الصلاح والغرض يلزم عليه سائر
المحدثات فإنه غير متقاصر في وحوده عنها فما هو الاعتذار عن أيجاد
المحدثات هو الاعتذار عن إيجاد الحادثات
فإن قيل ولم لا وقع
الاكتفاء في إيجاد المحدثات بما استند إليه الحادث كان ذلك محض مطالبة
واسترشاد وخروجا عما وقع الشروع في الكلام بصدده وهو إبطال قيام الحوادث
بذات الرب تعالى
المسلك الثالث
هو أنهم قالوا إن كان قوله وارادته من نوع اقوالنا وإرادتنا فما يحصل بقوله وإرادته وجب أن يحصل بأقوالنا وإرادتنا لكون الجميع من نوع واحد وحيث لم يحصل بأقوالنا وإرادتنا وجب أن لا يحصل بقوله وارادتهقالوا ولا يصلح أن يفرق بأن أقواله وارادته حاصلة بالقدرة القديمة والمشيئة الأزلية ولا كذلك أقوالنا وإرادتنا فان هذا في الحقيقة لا يصلح أن يكون فرقا إذ الفرق بين الشيئين يجب أن يكون بأمر يعود إلى نفسيهما لا إلى نسبتهما وان قيل إن الإيجاد إنما يحصل بالإرادة أو القول مع القدرة فالقدرة كافية في الإيجاد فلا حاجة إلى غيرها ثم لم لا جائز أن تحصل إرادتنا وأقوالنا مع ضميمة القدرة موجبة الإحداث أيضا إذ لا فرق بين أن يضاف إلى القدرة قوله أو قولنا وارادته وارادتنا لكونهما من نوع واحد
وهذا المسلك أيضا مما لا يقوى وذلك لأن ما نثبته نحن من الصفات القديمة للرب تعالى إن اعترفنا بأنها من نوع صفاتنا فالإلزام لخصومنا لازم علينا أيضا وان لم نقل بكونها من نوع صفاتنا فقد بطل الإلزام أيضا وان قدر اشتراكهما في الحدوث إذ ليس الاشتراك في شئ ما بين شيئين يوجب الاشتراك في الحقيقة كما لا يخفى ثم ولو قدر امتناع اضافة المحدثات إلى الصفة الحادثة فذلك لا يوجب امتناع قيام الحوادث بذات الرب تعالى
المسلك الرابع
قالوا لو جاز قيام الحوادث بذات الرب فلا بد أن يكون قاصدا لمحل حدوثها ومحل حدوثها ليس إلا ذاته فيجب أن يكون قاصدا لذاته والقصد إلى الشئ يستدعى كونه في الجهة وهو محال ثم ولجاز قيام كل حادث به وهو متعذروهذا المسلك أيضا مما يلتحق بما مضى في الفساد وذلك أنه إن أريد بالقصد العلم فذلك مما لا يوجب كون المقصود في الجهة وإن أريد به غير هذا فهو مما لا يسلمه الخصم ثم انه ان افتقر القصد عند إيجاد الحوادث إلى كونها في جهة فيلزم أن يكون القاصد أيضا في جهة لضرورة ان القصد إلى الجهة ممن ليس في جهة أيضا محال وذلك يفضى إلى كون البارى تعالى في جهة عند خلق الأعراض الخارجة عن ذاته ولا محيص عنه فما به الاعتذار ههنا يكون به الاعتذار للخصم ثم والقول بأنه إذا قيل حادثا لزم قبوله لكل حادث لا يخفى ما فيه من التحكم ومجرد الاسترسال مما ليس بمقبول ولا معقول
وقد ذكر في هذا الباب مسالك أخر فسادها أظهر من أن يخفى فلذا آثرنا الاعراض عن ذكرها
فالرأى الحق والسبيل الصدق والأقرب إلى التحقيق أن يقال لو جاز قيام الحوادث به لم يخل عند اتصافه بها اما أن توجب له نقصا أو كمالا أو لا نقص ولا كمال لا جائز أن يقال بكونها غير موجبة للكمال ولا النقصان فإن وجود الشئ بالنسبة إلى نفسه أشرف له من عدمه فما اتصف بوجود الشئ له وهو مما لا يوجب فوات
الموصوف ولا فوات كمال له وبالجملة لا يوجب له نقصا فلا
محالة أن اتصافه بوجود ذلك الوصف له أولى من اتصافه بعدمه لضرورة كون
العدم في نفسه مشروفا بالنسبة إلى مقابله من الوجود والوجود أشرف منه وما
أتصف بأشرف الأمرين من غير أن يوجب له في ذاته نقصا تكون نسبة الوجود إليه
فيما يرجع إلى النقص والكمال على نحو نسبة مقابله من العدم ولا محالة أن
كانت نسبته إلى وجود ذلك الوصف أشرف منه بالنسبة إلى عدمه ولا جائز أن
يقال إنها موجبة لكماله والا لوجب قدمها لضرورة ان لا يكون البارى ناقص
محتاجا إلى ناحية كمال في حال عدمها فبقى أن يكون اتصافه بها مما يوجب
القول بنقصه بالنسبة إلى حاله قبل ان يتصف بها وبالنسبة إلى ما لم يتصف
بها من الموجودات ومحال أن يكون الخالق مشروفا أو ناقصا بالنسبة إلى
المخلوق ولا من جهة ما كما مضى
فإن قيل لو لم يكن قابلا للحوادث
فعند وجود المسموعات والمبصرات إما أن يسمعها ويبصرها أو ليس لا جائز أن
يقال إنه لا يسمعها ولا يبصرها إذ هو خلاف المذهبين وإن أبصرها وسمعها فلا
محالة أن حصول ذلك له بعد ما لم يكن والا كانت المسموعات والمبصرات قديمة
لا محالة فلو لم يكن قابلا للحوادث حتى يخلق في ذاته سمعا وبصرا يكون به
الإدراك والا لما كان مدركا وهو محال
قلنا دعوى إدراكه المدركات بعد
ما لم يكن مدركا إما أن يراد به أنه لم يكن له إدراك فصار له إدراك أو
يقال بقدم الإدراك وتجدد تعلقه بالمدرك فإن قيل بالأول فهو محز الخلاف
وموضع الاعتساف فما بال الخصم مسترسلا بالدعوى من غير دليل مع
ما
قد عرف أن من أصولنا كونه سميعا بصيرا فيما لم يزل والمتجدد ليس إلا تعلق
الإدراك بالمدركات إذ شرط تعلق الإدراك بالمدركات وجود المدركات فإذا وجدت
تعلق بها أما أن يكون المتجدد هو نفس الإدراك فلا يخفى أن ما قضى بتجدده
ليس صفة قائمة بذات الرب تعالى فتجدده لا يلزم منه محال
وليس القول
بوجود الإدراك مع عدم المدرك بمستبعد فانه لا يتقاصر عن قول الخصم بأن ما
يحصل به الإدراك من الصفة الحادثة في الذات يبقى وإن زالت المدركات وعدمت
على ما عرف من أصله ومع الاعتراف بجواز الاتصاف بالإدراك وان زال المدرك
لا يرد الإشكال إذ لا فرق عند كون الشئ مدركا مع عدم المدرك بين ان يكون
المدرك قد تحقق له وجود أم لا على نحو ما حققناه في العلم
وإذا ثبت امتناع قيام الحوادث بذات الرب تعالى فقد بنى بعض الأصحاب على
ذلك امتناع كونه في الجهة وصيغته أن قال
لو كان البارى في جهة لم تخل الجهة إما أن تكون موجودة أو معدومة فإن كانت
معدومة فلا جهة إذ لا فرق بين قولنا إنه في جهة معدومة وبين قولنا إنه لا
في جهة إلا في مجرد اللفظ ولا نظر إليه
وأما إن كانت الجهة
موجودة فهى إما قديمة او حادثة لا جائز أن تكون قديمة وإلا أفضى إلى
اجتماع قديمين وهو محال ومع كونه محالا فهو خلاف مذهب الخصم ولا جائز ان
تكون حادثة وإلا كان البارى محلا للحوادث وهو محال
ولا يخفى ما في
هذا المسلك من التهافت فإنه وإن سلم أن الجهة موجودة وانها ليست قديمة بل
حادثة وانه يستحيل قيام الحوادث بذات الرب تعالى فلا يلزم من كونه في
الجهة ومن كونها حادثة ان تكون حالة في ذاته وان تكون ذاته محلا لها بل
المعنى بكونه في الجهة عند الخصم غير خارج عن النسبة الإضافية والأمور
التقديرية وذلك مما لا يوجب قيام صفة بالذات إذ لا يلزم من كون شيئين وجود
أحدهما مضاف إلى وجود الآخر من جهة ما أن يكون أحدهما قائما بالآخر أصلا
وهو على نحو كونه خالقا ومبدعا وغير ذلك
ولهذا لما تخيل بعض الأصحاب فساد هذا الطريق وانحرافه عن جادة التحقيق مر
في القول بنفى الجهة إلى مسلك آخر وقال
لو كان في جهة لم يخل اما أن يكون في كل جهة أو في جهة واحدة فإن كان في
كل جهة فلا جهة لنا الا والرب فيها وهو محال وإن كان في جهة مخصوصة فإما
أن يستحقها لذاته أو لمخصص لا جائز أن يستحقها لذاته إذ نسبة سائر الجهات
اليه على وتيرة واحدة فإذا لا بد من مخصص وإذ ذاك فالمحال لازم من وجهين
الأول أن المخصص إما أن يكون قديما أو حادثا فان كان قديما لزم
منه اجتماع
قديمين وهو محال وان كان حادثا استدعى في نفسه مخصصا آخر وذلك يفضى إلى
التسلسل وهو ممتنع
الوجه الثانى هو أن الاختصاص بالجهة صفة للرب
تعالى قائمة بذاته ولو افتقرت إلى مخصص لكانت في نفسها ممكنة لأن كل ما
افتقر في وجوده إلى غيره فهو باعتبار ذاته ممكن وذلك يوجب كون البارى
ممكنا بالنسبة إلى بعض جهاته والواجب بذاته يجب أن يكون واجبا من جميع
جهاته
ولا يخفى ما في هذا المسلك من الاسترسال فإنه لا يلزم من كونه
في جهة امتناع وجودنا فيها إلا على رأى من يزعم ان كونه في الجهة كون
الأجرام وأما على رأى من لم يقل بذلك فلا ولا ينافى وجوده في أى جهة قدر
وجود غيره بل وقول الخصم ههنا لا يتقاصر عن القول بأنه لا منافاة بين وجود
الجواهر والاعراض في حيز واحد مع ان الوجود لهما عينى وهما متحيزان وان
قدر أن التحيز للعرض عارض
وما قيل من أنه لو كان بجهة معينة لاستدعى
مخصصا فذلك مما لا ينكره الخصم ولكن القول بأنه لو كان المخصص قديما لأفضى
إلى اجتماع قديمين فإنما يلزم أن لو لم يكن المخصص هو نفس واجب الوجود اما
إذا كان نفسه فلا كما حققنا فيما مضى ولا يلزم من كون المخصص قديما أن
يكون ما خصص به أيضا قديما الا أن يكون مخصصا له بذاته وذلك مما لا يقول
به الخصم بل تخصيصه به انما هو على نحو تخصيص سائر
المحدثات
واستدعاء المخصص انما يلزم منه كون البارى واجبا من جهة وممكنا من جهة أن
لو قيل بأن الاختصاص بالجهة صفة نفسية وليس كذلك بل لقائل أن يقول إنها
صفة إضافية وكون الصفة الإضافية تستدعى مخصصا لا يوجب أن يكون المضاف فى
نفسه ممكنا ثم ولو قدر أنه بالإضافة إلى بعض صفاته ممكن فالمحال انما يلزم
أن لو كان المرجح له من تلك الجهة امرا خارجا عن ذاته وليس كذلك كما
أوضحناه ولا محالة ان هذه القوادح مما يعسر الجواب عنها جدا
فإذا
الواجب أن يقال لو كان البارى في جهة لم يخل إما أن يكون متحيزا بها او
ليس فان لم يكن متحيزا بها ولا هو مما تحيطه الأبعاد والامتدادات ولا هو
واقع في مسامتة الغايات والنهايات فلا معنى لكونه فيها الا من جهة اللفظ
ولا حاصل له وان كان متحيزا بها لزم أن يكون جوهرا فإن من نظر إلى ما هو
قابل للتحيز بجهة من الجواهر علم أن قبوله لها اما لذواتها ولكونها جواهر
أو لصفة قائمة بها وعلى كلا التقديرين يجب أن يكون البارى قابلا للتحيز
باعتبار ما قبل به غيره التحيز من الجواهر فإنه إن قبله باعتبار أمر آخر
فذلك الأمر الآخر اما ان يكون مخالفا للقابل من كل وجه أو من وجه دون وجه
فإن كان مخالفا له من كل وجه فيستحيل أن
يتفقا في قبول حكم واحد
وتأثير واحد فإنه مهما لم يكن بين القابل والمقبول مناسبة طبيعية بها يكون
أحدهما قابلا والآخر مقبولا والا لما تصور من المبدع اقتضاء قيام أحدهما
بالآخر لا بالإرادة ولا بالطبع كما لا يتصور منه اقتضاء قيام الجوهر
بالعرض والسواد بالبياض والبياض ب بالسواد واذا لم يكن بد من المناسبة
الطبيعية بين القابل والمقبول فالشيئان المختلفات من كل وجه ان قامت
بأحدهما أى مناسبة طبيعية استحال أن يكون الآخر مناسبا له من تلك الجهة
والا كان مماثلا له من جهة ما فيه من المناسبة وهو خلاف الفرض وان كان
مخالفا له من وجه وموافقا له من وجه فلا بد وأن يكون القبول باعتبار ما به
الاشتراك والإ لزم المحال السابق وهو ممتنع
وعلى هذا فإن كان قبول
ما فرض قبوله للتحيز من الجواهر لذاتها ولجوهرها لزم أن يكون البارى جوهرا
وهو ممتنع لما مضى وان كان باعتبار صفة قائمة به وهو قابل لها فلا بد وأن
تكون تلك الصفة قائمة بذات الرب لضرورة ما حققناه وعند ذلك فقبول الجوهر
لتلك الصفة إما لذاته او لصفة أخرى فان كان لصفة اخرى فإما أن يتسلسل
الأمر إلى غير النهاية أو ينتهى إلى صفة قبولها ليس الا لذات ما قامت به
من الجوهر لا جائز أن يقال بالأول لما فيه من الامتناع وان قيل بالثانى
لزم تناهى ذات واجب الموجود وذلك مع ما أوجبناه من الاشتراك في القابل
يوجب جعل ذات واجب الوجود جوهرا لكون ما انتهى إليه قبول التحيز من
الجواهر جوهرا لكن البارى ليس بجوهر كما سلف فليس في جهة
وما يخيل
من الاشتراك في قبول الوجود وغيره من الصفات كالعلم والقدرة ونحوه بين
الخالق والمخلوق مع اختلاف حقيقة القابل فمؤذن بقصور المتمسك به عن بلوغ
كمال
آلات الإدراكات ومصوت عليه بعجزه عن الارتقاء إلى درجة
النظر في المعقولات فإنه إن اعتقد أن الوجود نفس الموجود وأنه ليس بزائد
عليه فلا يخفى أن الاشتراك ليس إلا في التسمية دون المعنى والإشكال إذ ذاك
يكون مندفعا وان قدر أنه زائد على نفس الموجود فالواجب أن يعتقد اختلافه
في نفسه عند اختلاف قوابله لما مهدناه وأن لا يلتفت إلى ما وقع به
الاشتراك في الاسم وكذا في كل صفة يتخيل المشاركة فيها بين الخالق
والمخلوق وان لا يعول على من قصر فهمه وتبلد طبعه عن درك كل ما أشرنا إليه
من التحقيق ونبهنا عليه من التدقيق
فإن قيل لا محالة ان كل شيئين
قاما بانفسهما بحيث لا يكون احدهما محلا للآخر فإما ان يكونا متصلين أو
منفصلين وعلى كلا التقديرين فلا بد وان يكون كل واحد منهما بجهة من الآخر
والبارى والعالم كل واحد قائم بنفسه فإما أن يكونا متصلين أو منفصلين
وربما أورد عبارة أخرى فقيل إما أن يكون قد خلق العالم في ذاته أو خارجا
عن ذاته لا جائز أن يكون في ذاته والا كان محالا للحوادث وان كان خارجا عن
ذاته فهو في جهة منه وربما قيل إنه لو كان في غير جهة لبطل أن يكون داخل
العالم وخارجه وإثبات لوجود هذا حاله غير معقول وأيضا فإنا اتفقنا على أنه
ذو صفات قائمة بذاته ومن المعلوم أن الصفات ليس حيثها الا حيث وجود الذات
فإن القائم بغيره لا يكون له حيث الا حيث ما قام به فاذا حيث الصفات انما
هو حيث الذات وذلك يوجب كون واجب الوجود ذ ذا حيث وجهة
والجواب أما
الانفصال عما ذكر أولا من الاشكال فقد قال بعض المنتسبين إلى التحقيق إن
حاصله يرجع إلى المصادرة على المطلوب في الدليل مع تغيير في اللفظ
وذلك أن المباينة والمجامعة لا تكون الا من لوازم المتحيزات
وذوات الجهات
فاذا قيل إنه مباين أو مجامع فهو نفس المصادرة على المطلوب
وليس هذا
عند التحقيق مصادرة لأن المصادرة على المطلوب هو أن يؤخذ المطلوب بعينه
ويجعل مقدمة قياسية بلفظ مرادف مشعر بالمغيارة بين المقدمة والمطلوب
والمطلوب فيما عرضه إنما هو كونه في جهة أم لا وليس الجهة هى نفس الاتصال
ولا نفس الانفصال بل هى قابلة للاتصال والانفصال والانفصال والاتصال كل
واحد منهما لا يقبل الآخر ولهذا يصح أن نعقل الجهة ثم نعقل بعد ذلك كونها
متصلة أو منفصلة وإذا كان الاتصال والإنفصال غير الجهة التى هى نفس
المطلوب فالمأخوذ في الدليل إنما هو غير المطلوب لا عينه فإذا كان كذلك
فلا معنى للقول بالمصادرة ههنا فالواجب أن يقال
إنه إن اريد
بالإتصال والانفصال قيام أحدهما بذات الآخر وامتناع القيام فلا محالة أن
البارى والعالم كل واحد منهما منفصل عن الآخر بهذا الاعتبار وهو مما لا
يوجب كون كل واحد منهما في جهة من الآخر مع امتناع قبولية كل واحد منهما
لها أو امتناع قبولية أحدهما ومع امتناع تلك القبولية فلا تلزم الجهة وان
أريد بالاتصال ما يلازمة الاتحاد في الحيز والجهة وبالانفصال ما يلازمه
الاختلاف فيهما ووقوع البعد والامتداد بينهما فذلك إنما يلزم على البارى
تعالى ان لو كان قابلا للتحيز والجهة والا فان لم يكن قابلا فلا مانع من
خلوه عنهما معا فإن راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال والخصم لا يسلم
ذلك الا فيما هو قابل للجهة أفضى ذلك إلى الدور ولا محيص عنه وليس لهذا
مثال والا ما لو قال القائل وجود شئ ليس هو عالم ولا جاهل محال فيقال
انما هو محال فيما هو قابل لهما وكذا في كل ما هو قابل لأخد
نقيضين فان
خلوه عنهما محال أما وجود ما لا يقبل ولا لواحد منهما فخلوه عنهما ليس
بمحال وذلك كما في الحجر وغيره من الجمادات وبهذا يندفع ما ذكروه من
الخيال الآخر ايضا
وعدم التخيل لموجود هو لا داخل العالم ولا خارجه
على نحو تخيل الصور الجزئية مع كونه معلوما بالبرهان وواجبا التصديق به
غير مضر إذ ليس ما وجب التصديق به بالبرهان يكون حاصلا في الخيال والا لما
صح القول بوجود الصفات الغير المحسوسة كالعلم والقدرة والارادة ونحوه لعدم
حصولها في الخيال وامتناع وقوعها في المثال وما قيل من أن حيث الصفات لا
يكون إلا حيث الذات فذلك إنما هو لما كان من الصفات له حيث وجهة إذ يستحيل
أن تكون الصفات في جهة وحيث الا وهى في جهة ما قامت به من الذات ولا يتصور
وقوع الجهة للصفات دون الذات واما ما لا حيث له من الصفات فلا جهة له وعند
ذلك فلزوم الجهة والحيث لذات واجب الوجود بالنظر إلى حيث صفاته مع امتناع
قبولها للحيث محال
ولعل الخصم قد يتمسك ههنا بظواهر من الكتاب
والسنة وأقوال بعض الأئمة وهى بأسرها ظنية ولا يسوغ استعمالها في المسائل
القطعية فلهذا آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها
والله ولى التوفيق
القانون الخامس
في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعدالقاعدة الاولى
في أنه لا خالق الا الله تعالىفالذى إليه عصابة أهل الحق من الإسلاميين وغيرهم من الطوائف المحققين أنه لا خالق الا الله تعالى وأن وجوب وجود ما سواه ليس إلا عنه
وخالفهم في ذلك طائفة من الالهيين وجماعة من الثنوية والمعتزلة والمنجمين
فأحرى مبدوء به إنما هو البحث عن تفصيل مذهب كل فريق والاشارة إلى إبطال مآخذهم والكشف عن زيف مسالكهم
فمما ذهب اليه المعلم الأول ومن تابعه من الحكماء المتقدمين وقفا أثره من فلاسفة الإسلاميين أن البارى تعالى واحد من كل جهة وأنه لا يلحقه الانقسام والكم بوجه ما وانه ليس لذاته مبادئ يكون عنها ولا صفة زائدة عليها وبنوا على ذلك
ان الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وألا فلو صدر عنه اثنان لم
يخل إما ان يتماثلا من كل وجه او يختلفا من كل وجه أو يتماثلا من وجه
ويختلف من وجه فان تماثلا من كل وجه فهما شئ واحد ولا تعدد ولا كثرة وان
اختلفا من كل وجه أو من وجه دون وجه فهما في الجملة مختلفان وإذ ذاك
فصدورهما عما هو واحد من كل وجه ممتنع لأن صدورهما عنه إما أن يكون
باعتبار جهة واحدة أو باعتبار جهتين لا جائز ان يقال بالأول إذ الاختلاف
مع اتحاد الموجب محال ولا جائز أن يقال بالثانى والا فالجهات إما خارجة عن
ذاته او هى له في ذاته فإن كانت خارجة عن ذاته فالكلام فيها كالكلام في
الأول وذلك يفضى إلى التسلسل أو الدور وكلاهما محالان وان كانت لذاته وفي
ذاته فممتنع إذ هو واحد من كل وجه فلم يبق وإلا أن يكون الصادر عنه واحدا
لا تعدد فيه ولا كثرة
ولا يجوز ان يكون ذلك الواحد مادة ولا صورة
مادة إذ كل واحدة لا وجود لها دون الأخرى فإنا لو قدرنا وجود كل واحدة دون
الأخرى لم تخل اما أن تكون متحدة أو متكثرة فان كانت متحدة فهى لذاتها وما
اتحد منهما لذاته فالكثرة عليه مستحيلة والمواد والصور متكثرة وإن كانت
متكثرة فتكثر كل واحدة مع قطع النظر عن الأخرى محال كيف وإنه يلزم أن يكون
التكثر لذاتها ويلزم ان لا تتحد والوحدة عليها جائزة فإذا لا وجود لكل
واحدة إلا بالأخرى ويمتنع ان تكون إحداهما عله للأخرى إذ العلة وان كانت
مع معلولها في الوجود فلا بد وان تكون متقدمة عليه بالذات وليس ولا واحدة
من المادة والصورة متقدمة على الأخرى بالذات ولا بد ان تكونا مستندين إلى
موجود خارج عنهما وذلك الخارج لا يجوز ان يكون متعددا وإلا أفضى إلى
اجتماع الإلهين ولا جائز أن يكون متحدا لما سبق
وكما لا يجوز ان
يكون مادة ولا صورة مادة فكذا لا يجوز أن يكون نفسا فإن النفس وان لم يكن
وجودها ماديا فليس إلا مع المادة وإلا فلو كان لها وجود قبل مادة بدنها لم
يخل إما أن تكون متحدة أو متكثرة لا جائز ان تكون متحدة وإلا فعند وجود
الأبدان المتعددة إما أن تنقسم وهو محال إذ المتحد لا ينقسم واما ان تكون
النفس الواحدة لأبدان متعددة وهو ممتنع أيضا وإلا لاتحد الناس بأسرهم
في العلم بما يعلمه الواحد والجهل بما يجهله الواحد من حيث إن
النفس
المدركة واحدة ولا جائز أن تكون متكثرة قبل الأبدان إذ الكثرة والتعدد
للنفس بدون النظر إلى الأبدان وعلائقها محال وإذا ثبت أنه لا وجود للنفس
إلا مع وجود مادة بدنها امتنع أن يقال بصدورها عن المبدأ الأول لما حققناه
في المادة والصورة فإذا لا بد وأن يكون ما صدر عنه ماهية مجردة عن المادة
وعلائقها وعبروا عنه بالعقل الأول
وبتوسط هذا العقل يوجد عقل آخر
ونفس وجرم هو جرم الفلك الأقصى وبتوسط العقل الثانى يوجد عقل آخر ونفس
وجرم هو جرم فلك الكواكب وبتوسط العقل الثالث يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو
جرم فلك زحل وبتوسط العقل الرابع يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك
المشترى وبتوسط العقل الخامس يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك الشمس
وبتوسط العقل السادس يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك المريخ وبتوسط
العقل السابع يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك الزهرة وبتوسط العقل
الثامن يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك عطارد وبتوسط العقل التاسع يوجد
عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك القمر وبتوسط العقل العاشر وجدت العناصر
والمركبات وغير ذلك من الكائنات والفاسدات
وأما المنجمون
فقد اعتقد فريق منهم أن صدور الكائنات وحدوث الحادثات وكل ما يجرى في عالم
الكون والفساد ليس إلا عن الأفلاك الدائرة والكواكب السائرة وأنه لا مدبر
سواها ولا مكون إلاها
وقد تحاشى فريق منهم عن سخف هذه الحالة وتشنيع
هذه المقالة فقالوا المدبر والخالق ليس إلا الله تعالى لكن بتوسط الأجرام
الفلكية والكواكب السماوية
وأما الثنوية
فاعتقادهم ان مبدأ
الكائنات وكل ما في العالم من خير وشر ونفع وضر ليس هو إلا امتزاج النور
والظلمة وأنهما أصل العلوم فما يحصل من الخير فمضاف إلى النور وما يحصل من
الشر فمضاف إلى الظلمة
لكن منهم من ذهب إلى أن النور قديم والظلمة حادثة عن فكرة ردية حصلت لبعض
أجزاء النور وعبروا عن النور بالبارى وعن الظملة بالشيطان
ومنهم من قال بأنهما قديمان
وأما المعتزلة
فمطبقون على أن أفعال العباد المختارين مخلوقة لهم وأنها غير داخلة في
مقدورات الرب تعالى كما أن مقدورات الرب غير داخلة في مقدوراتهم
وقد نقل عن القاضى رحمه الله انه لم يثبت للقدرة الحادثة أثر في
الفعل بل
أثبت لها أثرا في صفة زائدة على الفعل كما سنبينه ثم اختلف قوله في الأثر
الزائد فقال تارة إنه لا اثر للقدرة القديمة فيه اصلا وقال تارة بالتأثير
وأثبت مخلوقا بين خالقين
وقد نقل عن الأسفرايينى أنه قال في نفس الفعل ما قاله القاضى في القول
الثانى في الاثر الزائد
وذهب إمام الحرمين في بعض تصانيفه إلى تأثير القدرة الحادثة في إيجاد
الفعل ولم يجعل للقدرة القديمة فيه تأثيرا إلا بواسطة إيجاد القدرة
الحادثة عليه
وذهب من عدا هؤلاء من أهل الحق إلى أن أفعال العباد
مضافة إليهم بالاكتساب وإلى الله تعالى بالخلق والاختراع وأنه لا أثر
للقدرة الحادثة فيها أصلا
وإذا عرف بالتحقيق مذهب كل فريق فلا بد من التعرض إلى إبطال مذاهب أهل
الضلال
وأول مبدوء به إنما هو الرد على طوائف الإلهيين القائلين بمنع صدور الكثرة
عن واجب الوجود
وهو أنا نقول عماد اعتقادكم ورأس اعتمادكم إنما هو آيل إلى نفى الصفات
الزائدة
على الذات وقد بينا فيما سلف سخف هذا المعتقد وتشنيع هذا المعتمد
ثم إن ما
أوجب لكم القول بمنع صدور الكثرة عن واجب الوجود إنما هو كونه واحدا وأن
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ولا بد لكم في هذه الدعوى من العود إلى هدم
ما بنيتموه ونقض ما أبرمتموه وذلك أنه لو لزم من كونه واحدا وحدة ما صدر
عنه فيجب أن يكون ما صدر عن معلوله ايضا واحد لكونه واحد وهكذا لا يزال
الحكم بصدور الواحد دائماوهو مما يوجب امتناع وقوع الكثرة في المعلولات
وتناقض قولكم في صدور الكثرة عن المعلول الاول حيث قلتم إن المعلول الاول
يصدر عنه عقل آخر ونفس وجرم هو الفلك الأقصى ثم إن صدور الكثرة عن المعلول
الأول اما أن تكون وهو متحد أو متكثر فإن كان واحدا فقد ناقض قولكم إن
الواحد لا يصدر عنه الا واحد فهلا قلتم بصدور الكثرة عن واجب الوجود وان
كان واحدا كما قلتم بصدور الكثرة عما صدر عنه وهو واحد وان قلتم إن ما صدر
عنه الكثرة متكثر فقد قلتم بصدور الكثرة عن واجب الوجود وأفسدتم ما ظننتم
إحكامه وما رمتم إتقانه وذلك خسف القول والفعال
فإن قيل لا محالة أن
المعلول الاول واجب الوجود بالواجب بذاته وكل ما هو واجب بغيره فهو ممكن
باعبتار ذاته من حيث أن ذاته لا جائز أن تكون واجبة وإلا لما كن واجبا
بغيره ولا جائز أن تكون ممتنعة وإلا لما وجدت ولا بالغير فتعين أن يكون
باعتبار ذاته ممكنا وهو لا محالة يعلم ذاته ويعلم مبدأه وهذه الجهات كلها
ليست له عن
عن غيره بل هى أمور لازمة تابعه لذاته ما عدا وجوب
وجوده فإنه له عن مبدئه ومبدأ صدور الكثرة إنما هو عن هذه الجهات فإنه
باعتبار إضافته إلى واجب موجب لوجوده يوجب عقلا وباعتبار صلته بمدئه يوجب
صورة وباعتبار كونه ممكنا يوجب مادة ترتيبا للأشرف على الأشرف والأخس على
الأخس وهذه هى مبادئ صدور الكثرة ولولاها لما كانت الكثرة
قلنا هذه
العماية والجهالة قد تعظم نسبتها إلى الصبيان فضلا عن من ينسب إلى شئ من
التحقيق والغوص والتدقيق وذلك لأن الجهات إما ان توجب التعدد والكثرة في
ذات المعلول الأول أول توجب التعدد والكثرة كالأمور السلبية والإضافية فإن
أوجبت التعدد والكثرة فقد قيل بصدور الكثرة عن واجب الوجود وان قيل لا
توجب التعدد والكثرة فلم لا قيل بصدور الكثرة عن واجب الوجود فإن السلوب
والإضافات له أكثر من ان تحصى هذا من حيث الإجمال
وأما التفصيل فهو
أن ما ذكروه من الجهات الموجبة للكثرة حاصلها يرجع إلى سلوب وإضافات فإن
وجوبه بغيره وعلمه بمبدئه وبذاته أمور إضافية وكونه ممكنا بذاته إن فسرنا
الممكن بما سلب عنه الضرورة في وجوده وعدمه كان أمرا سلبيا وإن فسر بما
يفتقر إلى المرجح في كلا طرفيه كان أمرا إضافيا وعند عودها إلى السلوب
والإضافات فيلزم عنها ما ذكر في الإجمال
كيف وأن قولهم إنه يعلم
مبدأه ويعلم ذاته دعوى لو سئلوا عن الدليل عليها لم يزد قولهم على أنه
باعتبار ذاته ممكن أن يكون عالما والمانع من العلم إنما هو المادة
وعلائقها وهى بأسرها منتفية فإن ماهيته مجردة عن المادة وعلائقها وهو أيضا
من أقبح المقالات وأعظم الشناعات فإن إمكان كونه عالما لا يوجب ولا يؤثر
في إيجاب العلم له وإلا كانت جهة الإمكان هى المرجحة لأحد الطرفين وهو
ممتنع
ونفى المانع مما لا يوجب أيضا فإن ثبوت الشئ إنما يستند
إلى ما يقتضيه أما إلى نفى المانع والمعارض فكلا ثم يلزمهم من ذلك مناقضة
قولهم إن البارى تعالى لا يعلم الجزئيات من حيث إن المانع هو المادة
وعلائقها وقد انتفت في حقه تعالى ثم إن كانت هذه الجهات مما توجب الكثرة
فلم قيل بانحصار ما صدر عنه في أربعة أشياء ولم لا كانت ازيد من ذلك فإن
مثل هذه الجهات لديه أكثر من ان تحصى فإذن حاصل ما ذكروه لا يرجع إلا إلى
محض تحكمات باردة وخيالات فاسدة لا يرضى بها لنفسه بعض المجانين فضلا عمن
يزعم انه من المحصلين
ب وأما المنجمون
القائلون بصنع الكواكب والأفلاك وأنه لا خالق ولا صانع سواها
فقد أكثر الأصحاب في الرد عليهم بأسولة باردة واستفسارات جامدة وإلزامات
لا ثبوت لها على محك النظر تليق بمناظرة العامة والصبيان فسادها يظهر
ببديهة العقل لمن له أدنى تحصيل لا يليق أن يطول بذكرها ههنا فالسبيل الحق
أن يقال لمن زعم منهم أن لا خالق إلاها ولا مبدأ سواها
إما أن تكون
باعتبار ذواتها واجبة أو ممكنة أو البعض منها واجب والبعض ممكن فإن كانت
واجبة فقد سلك الإلهيون في إبطال ذلك طريقة امتناع اجتماع واجبين وهى غير
مرضية كما سلف فالحق أنها لو كانت واجبة لكان وجودها سرمديا ولو كان
سرمديا لوجب القول بأن لا نهاية لحركاتها إن كانت متحركة في
القدم
ولمقادير حركاتها إن لم تكن متحركة وذلك ممتنع لما أسلفناه في تناهى العلل
والمعلولات
ثم إن الواجب لذاته هو ما لو فرض معدوما لزم المحال عنه
لذاته لا لغيره ولا يخفى أن القائل لو فرض بعقله عدم شئ من الكواكب
والأفلاك لم يلزم في عقله عن ذلك لذاته محال كما لا يلزم من فرض وجود فلك
آخر وكوكب آخر وما هو على هذا النحو كيف يكون الوجوب له لذاته بل إن فرض
واجبا فليس ذلك له إلا لغيره وكل ما وجوبه لغيره فهو بذاته ممكن كما سلف
كيف وان ذلك على أصلهم غير مستقيم لاعتقادهم ان تأليف الاجرام ليس إلا من
المواد والصور وقد بان أن كل واحد من المادة والصورة ليس وجوده الا بأمر
خارج عنها فهما لا محالة ممكنان وما مفرداته التى منها تأليفه ممكنة كيف
يكون هو لنفسه واجبا
ثم لو كانت واجبة لوجب ان ما شاركها في معنى
الجوهرية أن يكون واجبا إذ يستحيل أن يكون وجوب الوجود لما به تخصص جواهر
الأفلاك ومغايرتها لغيرها من الجواهر فإن ذلك لا قوام له بنفسه دون
المتخصص به وهو دور ممتنع وعند ذلك فيلزم على أصله امتناع القول بحدث
الجواهر الصورية الثابتة للأجرام العنصرية وكذا في الجواهر الانسانية التى
للأبدان الإنسانية على رأى من اعترف منهم بحدثها وبكونها جوهرا وهو لا
محالة تناقض وبما حققناه ههنا يتبين إبطال كون البعض منها واجبا دون البعض
فبقى أن تكون بأسرها ممكنة
وإذ ذاك فلا بد لها في وجودها من مرجح
خارج عنها وبطل القول بأنه لا مبدأ لها وأما من اعترف منهم بأن لها مبدأ
خارجا عنها لكنه أضاف الخلق إليها ووقف الإبداع والإحداث عليها فليس له في
دعواه مستند غير الاستقراء بأنا وجدنا التأثرات
المختلفة
والامتزاجات المتقاربة وجميع ما في عام الكون والفساد من خير وشر لا يوجد
إلا عند حركة كوكب مخصوص وذلك مما يوجب إسناده إليه وإحالة وجوده عليه إذ
لو كان اتفاقيا لما دام
ونحن نعلم أنهم لو طولبوا بصحة هذا
الاستقراء لم يجدوا الى اثباته سبيلا ثم لو قدرت صحته وان وقوع الآثار
الحادثة ملازم لحركات الكواكب والأفلاك فغير لازم أن تكون هى عللها
والأسباب الموجبة لها لما أنه لا مانع من أن يكون الخالق والبارى هو الله
تعالى وقد أجرى العادة بوجود الحادثات ووقوع التأثيرات عندها وإن منع بعض
الأصحاب من صحة هذا الاطلاق بناء على أن ما من جيشين تلاقيا او من نفسين
تخاصما ألا وقد أخذ الطالع لكل واحد منهما ومع ذلك فالمنصور والغالب لا
يكون إلا أحدهما فلا معول عليه إذ لا مانع من القول بخطأ الآخذ للطالع في
الحساب او الحكم وليس هذا موضع الاطناب ومحز الإسهاب والذى يجب الاعتماد
ههنا عليه ليس إلا ما أشرنا إليه
ج وأما الطريق
في الرد على
الثنوية القائلين بالنور والظلمة وانه لا مبدأ للعالم سواهما أن يقال إن
النور والظلمة بالنظر إلى ذاتيهما واجبان أو ممكنان أو أحدهما واجب والآخر
ممكن فإن كانا واجبين لزم أن ما شاركهما في نوعيهما أن يكون واجبا وأن لا
يكون موجودا بعد العدم وهو خلاف ما نشاهده من الأنوار والظلم وبه يتبين
امتناع كون أحدهما واجبا والآخر ممكنا فبقى أن يكونا ممكنين
وعند
ذلك إما أن يستند كل واحد منهما في وجوده إلى الآخر أو إلى أمر خارج عنهما
لا جائز أن يقال بالأول إذ هو دور ممتنع ومع كونه ممتنعا فغير مسلم صدور
الشر عن الخير والخير عن الشر لكون أحدهما خيرا والآخر شرا وهو تناقض وإن
كان المرجح لهما أمرا خارجا عنهما فقد بطل القول بأنه لا مبدا سواهما ولا
مرجح إلا هما ثم كفى بالخصم سخفا أنه لو سئل عن الدلالة على ما يعتقده
والإبانة عما يعتمده لم يزد على قوله
إنا وجدنا الموجودات لا تنفك
عن أن تكون ثقيلة تطلب أقصى جهة السفل أو خفيفة تطلب أقصى جهة العلو أو
ذات ظل حاجبة كالأشياء الكثيفة الغليظة من الحديد والحجارة ونحوها أو ما
هو على نقيضها من الأشياء الشفافة التى لا ظل لها كالزجاجة الصافية
واليواقيت ونحوها وبالجملة لا ينفك عن خيرات وشرور ولا بد من أن نرتب على
كل واحد ما يليق به ترتيبا للأشرف على الأشرف والأخس على الأخس وإلا كان
الأخس صادرا عن الأشرف والقبيح صادرا عن الحسن
وهو خلاف المعقول
فإنه مع ما يشتمل عليه من الركاكة والتحكم بتخصيص المبدأ بالنور والظلمة
لم يعلم أن مدلول اسم الشر ليس الا عبارة عن عدم ذات أو عدم كمال ذات وأن
الحسن والقبح ليس يستدعى اسناده الى ما هو في نفسه ذات ووجود حتى يلزم
التثنية على مالا يخفى
ثم ولو كان الشر والقبح ذاتا واستدعى أن يكون
مرجحه ذاتا فلا يخفى أن العالم ينقسم إلى ما هو خير محض و إلى ما هو شر
محض و إلى ما هو خير من وجه وشر من وجه ولا يوصف بكونه خيرا محضا ولا شرا
محضا ويجب من ذلك أن يكون من المبادئ ما هو خير من وجه وشر من وجه إذ
الخير المحض لا يصدر عنه إلا خير محض والشر المحض لا يصدر عنه إلا شر محض
وإن كان ذلك إنما يحصل بامتزاجهما فامتزاج
كل واحد منهما بالآخر
وحركته إليه إما لذاتيهما أو لمعنى زائد عليهما كما قال فريق منهم إن
الأصول ثلاثة نور محض وظلام محض وأصل ثالث ليس بنور ولا ظلام وهو دون
النور وفوق الظلام وهو الموجب لامتزاجهما والمعدل بينهما فإن كان لذاتيهما
فهو محال وإلا لما تصور الافتراق بينهما وهو خلاف ما نشاهده كيف وأن النور
والظلمة لذاتيهما متباينان فكيف يكون أحدهما طالبا للآخر وان كان ذلك
باعتبار امر ثالث فإما ان يكون من نوعها او من نوع احدهما او هو نوع ثالث
غيرهما فإن كان منهما فهو دور فإن امتزاجهما لا يتم إلا به وهو لا يتم إلا
بامتزاجهما وإن كان من نوع أحدهما فليس بأصل ثالث غيرهما وإذ ذاك فيعود
القسم الأول لا محالة وإن لم يكن من نوعهما فهو إما بسيط او مركب فإن كان
بسيطا فهو إما خير محض أو شر محض لعدم التركيب فيه وإذ ذاك فالصادر عنه
يجب أن يكون حاذيا حذوه وقافيا أثره وفي ذلك امتناع وجود قسم آخر غير الشر
المحض والخير المحض وهو ممتنع
د وأما الرد على المعتزلة
في خلق الأعمال فهو موضع غمرة ومحز إشكال وهو يستدعى تقديم طرق المتكلمين وإيضاح الصحيح منها والسقيم ثم الإشارة إلى شبه المخالفين وبيان الفرق بين الخلق والكسب فيما بعد إن شاء الله تعالى فنقول ذهب المتكلمون ههنا إلى مسالك لا ظهور لها عند من طهرت بصيرته واتقدت قريحتهالمسلك الأول
أنهم قالوا لو لم تكن مقدروات العباد مخلوقة لله تعالى لم يكن إلا لاستحالة مقدور بين قادرين وهو غير مستقيم فإنه قبل أن يقدر عبده لم يكن الفعل مقدورا للعبد فيجب أن يكون مقدورا للرب إذ الفعل في نفسه ممكن
والمانع من كونه قادرا بعد إقدار العبد إنما هو استحالة اجتماع مقدور بين
قادرين وهذا المانع غير موجود قبل إقدار العبد وإذا كان مقدورا للرب قبل
إقدار العبد فبعد إقداره يستحيل أن يخرج ما كان مقدورا له عن كونه مقدورا
فإنه لو خرج عن كونه مقدورا للرب بسبب تعلق القدرة الحادثة به لم يكن
بأولى من امتناع تعلق القدرة الحادثة به واستبقاء تعلق القدرة القديمة به
بل بقاء ما كان على ما كان أولى من نفيه وإثبات ما لم يكن وإذا ثبت كونه
مقدورا للرب وجب أن يكون خالقه ومبدعه من حيث إنه يستحيل انفراد العبد
بخلق ما هو مقدور لله تعالى
واعلم أن هذا المسلك من ركيك القول إذ
الخصم قد يمنع كونه مقدورا للرب قبل تعلق القدرة الحادثه به وكون الفعل في
نفسه ممكنا مما لا يوجب تعلق القدرة القديمة به أصلا ولا يعترف بأن كل
ممكن في نفسه مقدور للرب وما قدر من زوال المانع فمتهافت أيضا فإن الخصم
مهما لم يسلم إمكان تعلق القدرة القديمة بالفعل فلا يلزم من عدم ما يتخيل
في الجملة مانع أن يكون التعلق في نفسه ثابتا ثم ولو قدر كونه ممكنا فلا
يلزم التعلق من انتفاء المانع المعين مهما لم يتبين انتفاء غيره من
الموانع وذلك مما لا يتم إلا بالبحث وهو بعيد عن اليقينات كيف وإنه ولو
قدر مقدورا للرب فلا يلزم من حيث هو مقدور له أن تكون نسبته إليه أولى من
نسبته إلى العبد بكونه مقدورا له فإن قيل إنه يكون مخلوقا لهما فهو خلاف
المذهب ومع ذلك فهو محال لما سلف
المسلك الثانى
لو جاز تأثير القدرة الحادثة في الفعل بالإيجاد والاختراع لجاز تأثيرها في إيجاد كل موجود من حيث إن الوجود قضية واحدة لا يختلف وإن اختلفت محاله وجهاته والقول بجواز تأثيرها خلف فإنها لا تؤثر في إيجاد الأجسام ولا
فى شئ من الأعراض ما عدا الأفعال كالطعوم والألوان والأراييح ونحو ذلك وإن
كان التالى باطلا كان المقدم باطلا
وهو من الطراز الأول في الإبطال
فإن ما ألزمناه في الخلق والإبداع بعينه لازم لنا فيما أثبتناه من تعلق
القدرة الحادثة بإيجاد بعض الأشياء دون البعض وعند ذلك فجوابنا عنه هو
جواب لما ألزمناه
وليس من السديد أن يقال ما ثبت تعلق القدرة
الحادثة به لم يكن باعتبار معنى يشاركه فيه ما لم يكن متعلقا للقدرة
الحادثة بل ما هو متعلقها إنما هو بخصوص ذاته ومجموع صفاته وإذ ذاك فلا
يلزم أن تتعلق القدرة بغير تلك الذات مما هو مخالف لها في الحقيقة والصفات
فإن القدرة وإن تعلقت بالوجود وبغيره من الصفات الخاصة بالذات فلا يخرجها
ذلك عن أن تكون متعلقة بالوجود وعند ذلك فالاشكال لازم من جهة تعلقها
بالوجود لا من جهة تعلقها بغيره وإن قيل إنها لا تتعلق إلا بإيجاد مخصوص
هو لذات مخصوصة فلعل يوجد مثله في الخلق والإيجاد
وهو لا محالة لازم
على القاضى رحمه الله في قوله بتأثير القدرة في إيجاد صفة زائدة على الفعل
ولا محيص عنه لكن قد يبقى ههنا مناقشة جدلية ومؤاخذة معنوية وهو أن يقال
غاية ما ذكرتموه وأقصى ما أثبتموه أن ألزمتمونا على سياق ما ذكرناه ما
ألزمناكم إياه وأدنى ما فيه كونه حجرا على الفريقين ولازم للطائفتين وذلك
ما لا يوجب كونه في نفسه باطلا بل الواجب أن يقضى به على كلا المذهبين
والجواب على التحقيق عن هذه المؤاخذة إنما يتهيأ مع من يعترف
بالالزام
ويقول بالكسب ويعتقد صحته كما هو المنقول عن أهل الحق فإنه مهما اعترف
صاحب الدليل بمخالفته ووقوع مناقضته وكان مع ذلك جازما بالمخالفة معتقدا
لها فقد اعترف بأن ما ذكره لا يوجب الانقياد ولا يصلح للإرشاد وكفى مئونة
الجواب وأما من لا يعترف بذلك فلا
هذا كله إن قلنا إن الوجود زائد
على ذات الموجود وإلا فإن كان هو نفس الموجود فقد بطل القول بالاشتراك
والاتحاد في قضية الوجود وامتنع الإلزام
المسلك الثالث
قالوا البارى تعالى قادر على مثل جميع الأجناس التى هى مقدورة للعبد وإذ ذاك فيجب أن يكون قادرا عليها فإنه لو لم يكن يقدر عليها لم يكن قادرا على مثلها وهو خلف وإذا ثبت أنه قادر على أفعال العباد فإذا حدثت وجب أن تكون مخلوقة لهوهو قريب من المسلك الأول إذ الخصم قد يمنع كون الرب قادرا على مثل فعل العبد وإن سلم فأما أن يكون في محل قدرة العبد أو خارجا عن محل قدرته فإن كان في محل قدرة العبد فهو محل النزاع وموضع المنع وإن كان خارجا عن محل قدرة العبد فهو غير مقدور للعبد فإذا قيل بكون الرب قادرا على فعل العبد لكونه قادرا على مثله فيلزم أن يكون العبد قادرا على فعل الرب لكونه قادرا على مثله وهو محال ثم ولو سلم أنه قادر على فعل العبد فلا يلزم أن يكون خالقا له لم أسلفناه
ربما تمسك بعض الأصحاب
ههنا بظواهر الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة ولا مطمع لها في القطعيات
ولا معول عليها في اليقينيات فلذلك آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان
بإيرادها
والصواب في هذا الباب
أن يقال لو لم يكن فعل العبد بل
غيره من الموجودات الحادثة مقدورا للرب وداخلا تحت قدرته للزم أن يكون
البارى تعالى ناقصا بالنسبة إلى من له القدرة عليه كما مضى في الإرادة وهو
محال
ولئن تشوفنا إلى بيان إمتناع إضافة الخلق إلى فعل العبد قلنا
لم يخل إما أن يكون موجدا له بالذات أو بالإرادة لا جائز أن يكون موجدا له
بالذات وإلا لما برح فاعلا له وهو محال خلاف ما نشاهده ومع ذلك فهو خلاف
المذهبين ولا جائز أن يكون موجدا له بالإرادة وإلا لما وجد دونها فكم من
فعل يصدر من العبد ويعتقد كونه مخلوقا له من غير إرادة وذلك كما في حالة
الغفلة والذهول ونحوه والقول بكونه مريدا في مثل هذه الحالة عين السفسطة
فإنه لو سئل هل أردت ما فعلت لم يكن الجواب إلا بلا كيف وأن الفعل
بالإرادة من العبد يستدعى القصد والقصد يستدعى مقصودا والمقصود يستدعى
كونه معلوما وهو غير عالم به لا محالة وإن علمه من وجه لم يعلمه من كل وجه
ومع ذلك فصدوره عنه يكون على غاية من الحكمة والإتقان وعلى سبيل
الكمال والتمام فلو كان موجدا له بالإرادة لوجب كونه محيطا به
عالما
بأحواله إذ القصد و الإرادة لا يكونان إلا مع العلم ولا جائز أن يكون
متعلق قدرة العبد ما هو معلوم له ومتعلق قدرة البارى منه ما ليس بمعلوم
للعبد إذ مقدور كل واحد منهما قد لا يتم إلا مع تحقق مقدور الآخر ويلزم من
ذلك امتناع وجود الفعل في نفسه لما أسلفناه في مسألة التوحيد كيف وأن ذلك
مما لا قائل به وإذا جاز صدور الفعل عن العبد في مثل هذه الأحوال وقيل انه
مخلوق له من غير اراده فقد بطل أخذ الإرادة شرطا في الخلق وإذا لم تكن
الإرادة شرطا في الخلق بالنسبة إلى بعض أفعاله لم تكن شرطا بالنسبة إلى
سائر أفعاله وإن كان عالما بها مريدا لها إذ لا أولوية لأحدهما ومع ذلك
فلا قائل به ويلزم من إبطال تالى الشرطية بطلان مقدمها وهو المقصود وما
أشرنا إليه لازم على كل من جعل للقدرة الحادثة تأثيرا ما في إيجاد الفعل
أو في صفة زائدة عليه
فإن قيل إنا ندرك بالضرورة وقوع الأفعال على
حسب الدواعى والأغراض واختلاف المقاصد والإرادات ولولا صلاحية القدرة
الحادثة للإيجاد وإلا لما أحس من النفس ذلك وأيضا فإن الانسان يجد من نفسه
تفرقة بين الحركة الاضطرارية والحركة الاختيارية وليست التفرقة واقعة
بالنسبة إلى الحركتين من حيث هما ذاتان أو من حيث هما موجودان ولا غير ذلك
بل التفرقة إنما هى راجعة إلى كون إحداهما مقدورة
مرادة والأخرى
ليست مقدورة ولا مرادة وإذا لم تكن التفرقة إلا لتعلق القدرة بإحداهما دون
الأخرى فلا يخلو إما أن يكون لتعلق القدرة تأثير أو ليس لها تأثير لا جائز
أن يقال بأنه لا تأثير لها وإلا لما حصلت التفرقة إذ لا فرق بين انتفاء
التعلق وبين ثبوته مع انتفاء التأثير فيما يرجع إلى التفرقة فتعين القول
بالتأثير
قال القاضى أبو بكر من أصحابنا رحمه الله ولا جائز أن يكون
التأثير في إيجاد الفعل وإلا لما وقع الفرق إذ الوجود من حيث هو وجود لا
يختلف فيجب أن يكون راجعا إلى صفة زائدة على إحداث الفعل لكنه قال تارة في
الأمر الزائد إنه مخلوق للرب وللعبد هربا من شنيع إفراد العبد بالخلق دون
الرب وقال تارة بإنفراد العبد به وهو ما بين شنيع القول بالإنفراد والقول
بمخلوق بين خالقين وسيأتى وجه الكلام عليه فيما بعد
وربما تمسك
الخصم بأن أفعال العباد لو كانت مخلوقة لغيرهم كان التكليف في نفسه باطلا
فإن حاصله يرجع إلى المطالبة بفعل الغير والتكيلف بالفعل لمن لا يفعله
وليس طلب ذلك منه إلا على نحو طلب إحداث الأجسام وأنواع الأكوان وهو محال
ولبطل أيضا معنى الثواب والعقاب على الأفعال والمجازاة على الأعمال من حيث
إن الحكم بذلك للشخص بسبب فعل غيره حارف عن مذاق العقول وما ورد به الشرع
المنقول وهذه الشبهة هى التى أوقعت إمام الحرمين والإسفرايينى رحمهما الله
فيما ذهب إليه واعتمدا عليه
والجواب
أما وقوع الأفعال على
حسب الدواعى والأغراض فذلك مما لا يدل على صلاحية القدرة الحادثة للإيجاد
إذ الخلل لائح في خلاله والزلل واقع فى أرجائه من حيث إن الأشياء منها ما
يقع على حسب الدواعى ولا يضاف إلى القدرة الحادثة ولا يدل على صلاحيتها
للإيجاد وذلك كما فى حصول الرى عند الشرب والشبع عند الأكل وحصول الألوان
في صناعة الصبغ ونحو ذلك ومنها ما لا يقع على حسب الداعية والغرض وذلك كما
في أفعال النائم والغافل والساهى ونحو ذلك ومع ذلك هى مضافة إلى القدرة
الحادثة على أصلهم وحيث لم يصح ما عولوا عليه طردا وعكسا لم يجز الاعتماد
عليه أصلا
وما نجده من التفرقة بين الحركة الاضطرارية والاختيارية
فهو سبيلنا في إثبات الكسب على من أنكره من الجبرية وقال إن القدرة
الحادثة لا تعلق لها بالفعل أصلا ولزوم التأثير من وقوع التفرقة هو محز
الخلاف وموضع الانحراف بل التفرقة قد تحصل بمجرد تعلق القدرة بأحدهما دون
الآخر وإن لم يكن لها تأثير في إيجاده وذلك على نحو وقوع التفرقة بين ما
تعلق به العلم وبين غيره وبين ما تعلقت به الإرادة وبين غيره وإذ ذاك فلا
يلزم أن يقال إذا جاز تعلق القدرة الحادثة بالفعل من غير تأثير كما في
العلم ونحوه جاز تعلقها بغيره من الحوادث كما في العلم فإن حاصله يرجع إلى
دعوى مجردة في المعقولات ومحض استرسال في اليقينيات وهو غير مقبول
وكون الوجود قضية واحدة مما لا يوجب تعلق القدرة به بطريق العموم وما هو
اعتذارنا في تخصيص تعلق القدرة به من غير تأثير هو أن من موجب اعتقادهم
أن الرؤية تتعلق بالموجود من غير تأثير ولا تتعلق بكل موجود فما
هو اعتذارهم ثم هو اعتذارنا ههنا أيضا
وما اعتمده القاضى أبو بكر رحمه الله في منع تعليق القدرة بحدوث الفعل من
حيث إن الوجود قضية عامة فإما ان يعترف ان نفس الوجود هو نفس الموجود او
زائد عليه فإن كان الأول فقد بطل القول بالتعميم وإن كان الثانى فهو لازم
له في تعلقها بحدوث الصفة الزائدة أيضا اللهم إلا أن يجعل التعلق بحدوث
الصفة من حيث هو مخصوص بها وعند ذلك فيجب قبول القول بأن تعلق القدرة
الحادثة ليس إلا بحدوث مخصوص بفعل مخصوص ولا محيص عنه ثم ولو قدر تعلق
القدرة بزائد على نفس الفعل فلا يلزم أن يقال بتأثيرها فيه أيضا لما
أسلفناه في نفس الفعل وما اعتمد عليه بعض الأصحاب في إبطال قول القاضى في
أن ما ثبت تعلق القدرة به مجهول غير معلوم فلست أراه مرضيا
وما أشير
إليه من امتناع وقوع التكليف وتعذر القول بالمجازاة على الأفعال بالثواب
والعقاب وأن ذلك تكليف بما لا يطاق فسيرد وجه الانفصال عنه فيما بعد إن
شاء الله تعالى
وما يخص الإسفرايينى فيما ذهب إليه من إثبات مخلوق بين خالقين فقد سبق وجه
إحالته وظهر زيف مقالته فيما مضى فلا حاجة إلى إعادته
وعند هذا فيجب أن نختم الكلام بذكر الكسب والخلق تمييزا لكل
واحد منهما عن الآخر
أما الكسب فأحسن ما قيل فيه إنه المقدور بالقدرة الحادثة وقيل هو المقدور
القائم بمحل القدرة
وأما الخلق فإنه وإن أطلق باعتبارات مختلفة كالتقدير والهم باشئ والعزم
عليه والإخبار بالشئ على خلاف ما هو عليه فالمراد بالخلق المضاف إلى
القدرة القديمة إنما هو عبارة عن المقدور بالقدرة القديمة وإن شئت قلت هو
المقدور القائم بغير محل القدرة عليه
وما أشرنا إليه فكاف لمن لديه أدنى حظ من التفطن والله المستعان
القاعدة الثانية
في نفى الغرض والمقصود عن أفعال واجب الوجودمذهب أهل الحق أن البارى تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه ولا لمقصود أوجب الفعل عليه بل الخلق وأن لا خلق له جائزان وهما بالنسبة إليه سيان
ووافقهم على ذلك طوائف الإلهيين وجهابذة الحكماء المتقدمين
وذهبت طوائف المعتزلة إلى أن البارى لا يخلو فعله عن غرض وصلاح للخلق إذ هو يتعالى ويتقدس عن الأغراض وعن الضرر والانتقاع فرعاية الصلاح في فعله واجبة نفيا للعبث في الحكم عن حكمته وابطالا للسفه عنه في إبداعه وصنعته واما الأصلح فهم فيه مختلفون طائفة ألحقته بالصلاح في وجوب الرعاية وطائفة أحالت القول بوجوبه بناء على أن ما من صالح إلا وفوقه ما هو أصلح منه إلى غير نهاية ثم بنوا على وجوب رعاية الصلاح والأصلح باتفاق منهم وجوب الثواب
على الطاعات والآلام الغير المستحقة كما في حق البهائم والصبيان
ووجوب
العقاب وإحباط العمل على العصيان ووجوب قبول التوبة والإرشاد بعد الخلق
وإيصال العقل إلى وجوه المصالح بالإقدار عليها وإقامته الآيات والحجج
الداعية إليها
ثم التزموا على فاسد أصلهم أن ما ينال العبد في الحال
أو المآل من الآلام والأوجاع والنفع والضر والخير والشر ونحوه فهو الصالح
له ولم يتحاشوا جحد الضرورة ومكابرة العقل في أن خلود أهل النار في النار
هو الصالح لهم والأنفع لنفوسهم
ومما فارق به البغداديون البصريين
القول بوجوب ابتداء خلق الخلق وتهيئة أسباب التكليف من إكمال العقل
واستعداد الآلات للتكليف إلى غير ذلك والبصريون لا يرون أن شيئا من ذلك
واجب بل ابتداؤه بفضل من الله تعالى وإنعام من غير تحقق ولا تحتم ولا
إلزام
ونحن الآن نبتدئ بمأخذ أهل الحق والكشف عنه ثم نشير بعد ذلك إلى مأخذ أهل
الضلال والإبانة عن معرضها في معرض الاعتراض والانفصال
فمما اعتمد عليه أهل التحقيق
في هذا الطريق أن قالوا لو كان إبداع البارى تعالى لما أبدعه يستند إلى
غرض مقصود لم يخل إما ان يقال بعوده إلى الخالق أو إلى المخلوق فإن كان
عائدا إلى الخالق لم يخل إما أن يكون بالنسبة إليه كونه أولى من لا كونه
أو لا كونه أولى من كونه أو أن كونه وأن لا كونه بالنسبة إليه سيان
فإن قيل إن كونه أولى من لا كونه فلا محالة أن واجب الوجود يستفيد بذلك
الفعل كما لا وتماما لم يكن له قبله لكونه أولى بالنسبة إليه وتركه وأن لا
يفعله نقصانا وذلك يوجب افتقار الأشرف إلى الأخس في إفادة كمالاته له وأن
يكون ناقصا قبله ونعوذ بالله من هذا الضلال بل هو الغنى المطلق وله الكمال
الأتم والجمال الأعظم وهو مبدأ الكمالات ومنتهى المطالب والأمنيات وإليه
الافتقار في جميع الحالات وليس له في فعله مطلوب يكمله ولا له قصد إلى
ثناء أو مدح يحصله بل هو الغنى له ما في السموات والأرض وهو على كل شئ
قدير
وإن قيل إن لا كونه أرجح من كونه أو أنهما متساويان فالقول
بجعل مثل هذا غرضا ومقصودا مع أنه لا فرق بين كونه وأن لا كونه أو أن لا
كونه أولى من كونه من أمحل المحالات
وإن قيل برجوعه إلى المخلوق
من صلاح أو نفع فأى فائدة في خلق ما في العالم من الجمادات والعناصر
والمعدنيات وغير ذلك من أنواع النباتات مع أنها لا تجد بذلك لذة ولا ألما
ولا فرق لها بين كونها وأن لا كونها بل وأى فائدة لنوع الحيوان في ذلك أو
لتكليف نوع الإنسان مع ما يجد فيه من الآلام والأوصاب والمشاق والأوجاع
وكل ما تجد النفس من تحلمه حرجا
وكل عاقل إذا راجع نفسه بين الوجود
وأن لا وجود فإنه يود لو أنه لم يكن موجودا لما أعد له في الأولى والعقبى
ولهذا نقل عن الأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين التكره لذلك والتبرم
به حتى إن بعضهم قال يا ليتنى كنت نسيا منسيا وقال آخر يا ليتنى لم تلدنى
أمى وقال آخر يا ليتنى لم أك شيئا
بل وأى نفع وصلاح للعبد في خلوده
في الجحيم وإقامته في العذاب الأليم وكذا اى مصلحة في انظار إبليس وإضلاله
وإماتة الأنبياء مع هدايتهم وهل من زعم ان في ذلك صلاحا أو نفعا إلا خارقا
لحجاب الهيبة بارتكاب جحد الضروة
ثم الذى يقطع دابر هذا الخيال ودفع هذا الإشكال إبداء ما وقع من أفعال
الله تعالى
مع تسليم الخصم ضرورة أنه لا صلاح فيه ولا أصلحية وذلك أنا لو
فرضنا ثلاثة
أطفال مات أحدهم وهو مسلم قبل البلوغ وبلغ الآخران ومات أحدهما مسلما
والآخر كافرا فمن مقتضى أصولهم على ما استدعاه التعديل ان تكون رتبة
المسلم البالغ فوق رتبة الصبى لكونه أطاع بالغا وتخليد الكافر في الجحيم
لكونه كان عاصيا فلو قال الصبى يا رب العالمين لم اخترمتنى دون المرتبة
العلية والرفعة السنية التى أعطيتها لأخى ولم تمنعه إياها و لم لا أحييتنى
إلى حين البلوغ لأطيعك فتحصل لى هذه الرتبة وأى مصلحة لى في إماتتى قبل
البلوغ وقطعى عن هذه الرتبة فلا جواب الا ان يقول له لأنى علمت منك انك لو
بلغت لعصيتنى فكان اخترامك هو الأنفع لك وانحطاطك إلى هذا الرتبة أصلح
لنفسك لكن ذلك مما يوجب اخترام كل من علم الله كفره عند البلوغ ولا يبقى
لإحياء ذلك الكافر البالغ معنى ولا يتجه عنه جواب
فقد بان من هذه الجملة أن الغرض في أفعال الله تعالى ووجوب رعاية الصلاح
والأصلح عليه مستحيل
وما يخص رعاية الأصلح أن يقال
مقدورات الله تعالى في الأصلح غير متناهية ورعاية ما لا سبيل إلى الوقوف
فيه على حد وضابط ممتنع ثم ولو وجب في حقه رعاية الصلاح والأصلح للزم أن
تكون الهبات والنوافل بالنسبة إلى أفعالنا واجبة لما فيها من صلاحنا إذ
الرب تعالى لا يندب
إلى ما صلاح لنا فيه ولا معنى للفرق في ذلك
بين الغائب والشاهد أصلا كيف وأن أصل الخصم فيما يرجع إلى وجوب رعاية
الصلاح والأصلح في حق البارى تعالى ليس إلا بالنظر إلى الشاهد وهو ممتنع
لما حققناه في غير موضع
كيف وقد سلم أن الواحد منا لا يجب عليه
رعاية الصلاح والأصلح في حق نفسه مع تمكنه من تحصيله فأنى يصح القياس على
هذا الأصل مع تحقق هذا الفصل وهل ذلك إلا خبط في عشواء
وإذا تحقق ما
قررناه من امتناع الغرض في أفعاله ووجوب رعاية الصلاح والأصلح لزم منه هدم
ما بنى عليه من وجوب الثواب والعقاب والخلق والتكليف وغير ذلك مما عددناه
من مذهبهم فإنهم لم يقضوا بوجوبه إلا بناء على رعاية الصلاح والأصلح لا
محالة
ثم إن الواجب قد يطلق على الساقط ومنه يقال للشمس والحائط
إنهما واجبان عند سقوطهما وقد يطلق على ما يلحق بتاركه ضرر وقد يطلق على
ما يلزم من فرض عدمه المحال والمفهوم من إطلاق اسم الوجب ليس الا ما
ذكرناه وما سواه فليس بمفهوم ولا محالة أن الواجب بالاعتبار الأول غير
مراد والثانى فقد بان أنه مستحيل في حق الله تعالى لانتفاء الأغراض عنه
والثالث أيضا لا سبيل إلى القول به إذ الخصوم متفقون على وجوب التمكين مما
كلف به العبد وكيف يمكن حمل الوجوب
على هذا الاعتبار مع الاعتراف بتكليف أبى جهل بالإيمان وهو
ممنوع منه لعلم الله تعالى أن ذلك منه غير واقع ولا هو إليه واصل
فإن قيل لو لم يكن فعل واجب الوجود لغرض مقصود مع ان الدليل قد دل على
كونه حكيما في أفعاله غير عابث في إبداعه لكان عابثا والعبث قبيح والقبيح
لا يصدر من الحكيم المطلق والخير المحض وإذا لا بد له في فعله من غرض
يقصده ومطلوب يعتمده نفيا للنقص عنه وتنزيها له عن صدور القبيح منه وما
ذكرتموه من تعلق النقص والكمال به بالنظر إلى الغرض والمقصود فإنما يلزم
أن لو كان ذلك الغرض عائدا اليه وكماله ونقصه متوقفا عليه وليس كذلك بل هو
الغنى المطلق واستغناء كل ما سواه ليس إلا به بل عوده إنما هو الى المخلوق
وذلك مما لا يوجب كمالا ولا نقصانا بالنسبة إلى واجب الوجود وإذا ثبت أنه
لا بد من حكمة وفائدة ففائدة خلق العناصر والمركبات والمعدنيات وغير ذلك
من الجمادات العناية بنوع الحيوان لأجل انتظام أحواله في مهماته وأفعاله
والاستدلال بما في طيها من الآيات والدلائل الباهرات على وجود واجب الوجود
ووحدانية المعبود وإليه الإشارة بقوله عليه السلام كنت كنزا لم أعرف فخلقت
خلقا لأعرف به
وما يلحق الإنسان من مشقة التكليف والآلام في
الدنيا فبالنظر إلى ما يناله على ذلك من الثواب في العقبى قليل من كثير
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل
سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء ولا محالة أن فوات الخير الكثير دفعا
للشر اليسير شر كثير والتزام الشر اليسير رعاية للخير الكثير خير كثير
وفائدة خلود أهل النار في النار كفهم عن الكفر والفساد والعناد والشقاق
والنفاق ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من ذلك فهو الأصلح لهم ثم لا ينكر
أن العلة قد تخفى وتدق عن أن تصل إليه أفهام الخلق كما في إماتة الأنبياء
وإنظار ابليس وإحياء من علم كفره إلى حيث البلوغ ونحوه فمجرد استبعاد
العلة لخفائها وعدم الاطلاع عليها مما لا يفيد لأنه لا يلزم من عدم
الاطلاع عليها القول بانتفائها في نفسها
ولا يلزم من وجوب رعاية
الصلاح في حق الله تعالى وجوب النوافل بالنسبة إلى أفعالنا لكونها صالحة
فإن رعاية ذلك بطريق الوجوب بالنسبة إلى أفعالنا مما يوجب الكد والجهد في
حقنا ولا كذلك البارى تعالى فانه قادر على نفع الغير وصلاحه من غير أن
يلتحق به جهد ولا ضرر فلذلك جاز القول بإيجاب الفعل الصلاح في حق البارى
دون غيره ولهذا المعنى لم نقل بوجوب رعاية الصلاح والأصلح في حق الواحد
منا مع تمكنه منه
وليس القول بوجوب رعاية الصلاح في حق الغائب
بالقياس على الشاهد ليلزم ما ذكرتموه بل هو مستند إلى ما ذكرناه من إحالة
صدور القبيح والعبث عن واجب الوجود كما بيناه
وما ذكرتموه من
امتناع رعاية الأصلح فإنما يلزم أن لو لم يكن ما تجب رعايته مقدرا ومضبوطا
وضبط ذلك وتقديره مما يعلم الله تعالى أن الزيادة عليه مما يوجب للعبد
العتو والطغيان والكفران والعناد ولا محالة أن رعاية مثل ذلك لا يفضى إلى
محال
وما وقعت الإشارة إليه من أقسام مدلولات الواجب مما لا ننكره
ولا ننكر امتناع الوجوب في حق الله تعالى بالإعتبار الأول والثانى إنما
النزاع في الاعتبار الثالث فإن معنى كون الفعل واجبا على الله تعالى ليس
إلا أنه يلزم من فرض عدمه المحال وذلك المحال ليس هو لازما من فرض عدم
الفعل لذاته بل لغيره فمعنى كون الصلاح في الفعل واجب الرعاية أنه يلزم من
فرض عدمه العبث في حق الله وهو محال ومعنى كون الثواب على إيلام الحيوان
واجبا أنه يلزم الظلم من فرض عدمه في حق الله تعالى وصدور القبيح منه وهو
محال ولهذا صارت التناسخية إلى أن ذلك لا يقع إلا جزاء منه لها على ما
فرطت واقترفت من الكبائر والجناية حين كانت أنفسها في قوالب أشرف وأحسن من
قوالب الحيوان
ومن الناس من جعله قبيحا لعينه وذاته ثم منهم من
اضافه إلى ظلمه كالتناسخية ومنهم من لم يسلم وجوده كالبكرية فما ظنك به مع
خلوه عن الجزاء المقابل وعلى هذا كل ما يوصف بالوجود من أفعال الله تعالى
أما قصة أبى جهل فلا احتجاج بها فإن ما كلفه به ممكن في نفسه
ومتمكن منه
بكونه مقدورا له فلم يكن ما أوجبناه من التمكين غير واقع ولا متصور
والجواب
إننا لا ننكر كون البارى تعالى حكيما وذلك بتحقق ما يتقنه من صنعته ويخلقه
على وفق علمه به وبإرادته لا بأن يكون له فيما يفعله غرض ومقصود والعبث
إنما يكون لازما له بانتفاء الغرض عنه أن لو كان قابلا للفوائد والاغراض
وإلا فتسميته غرضا عن طريق التوسع والمجاز هو غير ممكن كمن يصف الرياح في
هبوبها والمياه عند خريرها والنار عند زئيرها بكونها عابثة إذ لا غرض لها
ولا غاية تستند إليها ولا يخفى ما في ذلك من التحجير بوضع ما أصل له في
الوضع
وأما تقبيح صدوره من البارى تعالى فمبنى على فاسد أصلهم في
التحسين والتقبيح والرد عليهم في ذلك يستدعى تقرير المذهب من الجانبين
وتمهيد القاعدة من كلا الطرفين فنقول
معتقد المعتزلة أن الحسن
والقبح للحسن والقبيح صفات ذاتيات ووافقهم على ذلك الفلاسفة ومنكروا
النبوات ثم اختلف هؤلاء في مدارك الإدراك لذلك فقالت المعتزلة
والفلاسفة المدرك قد يكون عقليا وقد يكون سمعيا فما يدرك بالعقل
منه بديهى
كحسن العلم والإيمان وقبح الجهل والكفران ومنه نظرى كحسن الصدق المضر وقبح
الكذب النافع وما يدرك بالسمع فكحسن الطاعات وقبح ارتكاب المنهيات
وأما منكرو النبوات فقد منعوا أن يكون إدراكها إلا بالعقول دون شرع
المنقول
وأما أهل الحق فليس الحسن والقبح عندهم من الأوصاف الذاتية للمحال بل إن
وصف الشئ بكونه حسنا أو قبيحا فليس الا لتحسين الشرع أو تقبيحه إياه
بالإذن فيه او القضاء بالثواب عليه والمنع منه او القضاء بالعقاب عليه او
تقبيح العقل له باعتبار أمور خارجية ومعان مفارقة من الأعراض بسبب الأغراض
والتعلقات وذلك يختلف بإختلاف النسب والإضافات
فالحسن إذا ليس إلا ما أذن فيه أو مدح على فعله شرعا أو ما تعلق به غرض ما
عقلا
وكذا القبيح في مقابلته
وإطلاق الأصحاب أن الحسن والقبيح ليس إلا ما حسنه الشرع أو قبحه
فتوسع في
العبارة إذ لا سبيل إلى جحد أن ما وافق الغرض من جهة المعقول وأن لم يرد
به الشرع المنقول أنه يصح تسميته حسنا كما يسمى ما ورد الشرع بتسميته حسنا
كذلك وذلك كاستحسان ما وافق الأغراض من الجواهر والأعراض وغير ذلك وليس
المراد بإطلاقهم إن الحسن ما حسنه الشرع أنه لا يكون حسنا إلا ما أذن فيه
أو أخبر بمدح فاعله وكذا في جانب القبح أيضا
وبعد هذا فلم يبق إلا الرد على أهل الضلال وهو أن يقال
الحاكم بالحسن والقبح على ما حكم بكونه حسنا أو قبيحا إما العقل أو الشرع
لا محالة فإن كان الحاكم هو العقل فلا محالة أن ما حكم العقل به من
التحسين والتقبيح لو خلى ودواعى نفسه في مبدأ نشوئه إلى حين وفاته من غير
التفات إلى الشرائع والعادات والأمور الاصطلاحيات والموافقات للأغراض
والمنافرات لم يجد إلى الحكم الجزم بذلك سبيلا
وإذا لم يكن في الحكم
بهذه الأمور بد من النظر إلى ما قدرناه فهى لا محالة مختلفة بالنسبة
والإضافة إذ رب شئ حكم عليه عقل إنسان ما بكونه حسنا لكونه موافقا لغرضه
أو لما فيه من مصلحته أو دفع مفسدته أو لكونه جاريا على مقتضى عادته وعادة
قومه عرفا أو شرعا وقد يحكم عليه عقل غيره بكونه قبيحا لكونه مخالفا له
فيما وافق غرضه وذلك كالحكم على ذبح الحيوان بالحسن والقبح بالنسبة إلى
أهل الشرائع المختلفة وكالحكم بالحسن
والقبح على سمرة اللون مثل
بالنسبة إلى من يستحسنها أو يستقبحها وكالحكم بقبح الكذب الذى لا غرض فيه
وحسنه إذا قصد به إحقان دم نبى أو ولى من غاشم يقصد قتله وهلم جرا في كل
ما يقضى العقل باعتباره على كون الشئ حسنا أو قبيحا ولو كان ذلك ذاتيا لما
اختلف باعتبار النسب والإضافات بل لوجب أن يكون متحققا مع تحقق الذات وان
تغيرت الحالات كما في سائر الذاتيات
وان كان الحاكم به الشرع فلا
محالة أنه قد يحكم بكون القتل مثلا أو الكذب قبيحا في حق العاقل القاتل لا
لغرض ولا يحكم بقبح ذلك في حق الصبى والمجنون بل وقد يحكم بحسن شريعة ما
بالنسبة إلى قوم ويقبحها بالنسبة إلى آخرين ولهذا صح القول بنسخ الشرائع
ولو كان القضاء فيه بالحسن أو القبح على شئ ما لذاته ونفسه لا لنفس الخطاب
لما تصور أن يختلف ذلك باختلاف الأمم والأعصار على ما حققناه
فإن
قيل لو كان الأمر على ما ذكرتموه لوجب أن من أراد قضاء حاجة وكان سبيله
فيها إما الصدق وإما الكذب وهما بالنسبة إلى قضاء حاجته سيان أن لا يرجح
الصدق على الكذب وأن من رأى شخصا في الهلاك وهو قادر على إنقاذه وخلاصه
وليس له في إنقاذه غرض ولا هو متدين بدين بل ربما أوجب ذلك عنده تعبا
ونصبا أن لا يرجح عنده الإنقاذ على عدمه وهو مما تقضى العقول السليمة برده
وإبطاله وإذا ثبت الترجيح فلو لم يكن ذلك لحسنه في ذاته وإلا كان عبثا
وسفها ثم كيف ننكر ذلك والعقل الصريح
يقضى ببديهته على حسن العلم
والإيمان وقبح الجهل والكفران من غير توقف على أمر خارج أصلا ومن أنكر ذلك
فهو لا محالة معاند مجاحد مع أن اتفاق العقلاء على ذلك مما يخصمه
قلنا ما ذكرتموه من الإلزامات واعتمدتموه من الخيالات مهما قطع النظر فيها
عما ذكرناه من المقاصد والأغراض فالترجيح لا محالة يكون ممتنعا والمحتج به
يكون منقطعا ومهما لم يكن بد من الأغراض فيما حكم العقل بحسنه أو قبحه
امتنع أن يكون ذلك له ذاتيا كما مهدناه
ومن قضى بإطلاق التحسين لما
حسنه أو التقبيح لما قبحه من غير اقتصار على متعلق الغرض فليس ذلك إلا
لذهوله عن محز الغلط ومثار الفرط وهو إما حبه لنفسه وشغفه بما تعلق به غضه
فإنه قد يحكم إذ ذاك قطعا بحسن ما وافق غرضه وقبح ما خالفه من غير التفات
إلى غرض الغير لكونه غير مشغوف به وذلك كمن يحكم بحسن صورة ما أو قبحها
لما وافق من غرضه أو خالف مطلقا وإن جاز أن يكون غرض غيره مخالفا لغرضه
وقد يكون ذلك لكون ما يحكم بحسنه أو قبحه مما يوافق الأغراض غالبا ومخالفة
لها نادرا فيحكم عليه بكونه حسنا أو قبيحا مطلقا لخفاء موضع المخالفة عليه
وندرته في وقوعه وذلك كمن يحكم على الكذب بأنه قبيح مطلقا فلا يلتفت إلى
حسنه عندما يستفاد به عصمة دم نبى أو ولى لندرته وخفائه في نفسه ومثارات
الغلط في ذلك
متكثرة متعددة لا محالة ولا مستند للحكم بجهة
الإطلاق إلاها حتى لو فرض شخص ما متنبها عند حكمه على ما حكم فيه لجميع
مواضع الغلط ومواقع الزلل لما تصور منه القضاء بذلك مطلقا
وما ذكروه
من ادعاء الضرورة للعلم بحسن العلم والإيمان وقبح الجهل والكفران فمن أحاط
بما ذكرناه وفهم ما قررناه بان له وجه فساده من غير توقف ثم كيف يقنع
بالاسترسال في ادعاء ذلك مع ان أكثر العقلاء في ذلك لهم مخالفون وهم عما
يدعونه مدافعون ولو كان مجرد ذلك كافيا لاكتفى به من جحد الصانع وقضى
بالتجسيد والتشبيه وذلك مما يبطل القضايا العقلية والأمور النظرية وهو
ممتنع وليس اتفاق بعض العقلاء عليه مما يوجب كونه ضروريا وإلا للزم أن ما
اتفق عليه الخصوم أيضا ضرورى لكونهم من جملة العقلاء بل أكثرهم وذلك يفضى
إلى كون الشئ لواحد معلوما نفيه وإثباته في حالة واحدة بالضرورة وهو ممتنع
كيف وكم من شئ اتفق عليه أكثر العقلاء وليس بضرورى كما في حدث العالم
ووجود الصانع ونحوه بل لو قدر اتفاق المخالف لهم بحيث وقع الإطباق على ذلك
فإنه لا ينقلب ألبتة ضروريا على معنى أنه لو خلى الإنسان ودواعى نفسه يحكم
به من غير توقف على أمر ما
لم يبق إلا قولهم إن الاضطرار إلى معرفة
كون الحسن والقبح ذاتيا واقع لا محالة وإنما النزاع في مدركه ومن تنبه لما
أشرنا إليه علم أن ذلك غلط من قائله لوجهين
الوجه الأول أن ما حكموا
بتقبيحه فنحن قد نحكم بتحسينه وذلك كإيلام الحيوان وتعذيب الانسان من غير
ثواب ولا لغرض مقصود فكيف يدعى الموافقة على نفس الحسن والقبح وكونه ذاتيا
الوجه الثانى أنه وإن وقع الاتفاق على تحسين كل ما حسنوه وتقبيح
كل ما قبحوه فلم يقع الاتفاق على كون الحسن والقبح ذاتيا ولا يلزم من
الاتفاق على كون الشئ الواحد حسنا أو قبيحا أن يكون قد سلم كون الحسن
والقبح له ذا تبين
ولا يلزم من عدم جواز اتصاف البارى بكونه جاهلا
أن يكون ذلك لكون القبح للجهل وصفا لزاما وأنه لذاته قبيح بل لكون الدليل
القاطع قد دل على وجوب العلم له وكونه عالما ولو جوزنا أن يكون جاهلا
لجوزنا أن لا يكون عالما وذلك خلاف ما اقتضاه الدليل القاطع والا فلو
جوزنا النظر إلى مجرد الجهل لم يقتض ذلك كون القبح له ذاتيا فإنه وان صح
تقبيحه بالنسبة إلى من خالف غرضه بسبب عدم اطلاعه على المعلومات وإحاطته
بالمعقولات فقد علم بحسنه من وافق جهل هذا الجاهل غرضه وذلك كما نحكم على
كون القتل قبيحا بالنسبة إلى المقتول وأوليائه وتحسينه بالنسبة إلى حساده
واعدائه وهذا واضح لا خفاء به وبهذا التحقيق يقع التفصى عن كل ما يرد من
هذا القبيل
وإذا بطل أن يكون الحسن والقبح ذاتيا لم يبق معنى للحسن
والقبح إلا ما ذكرناه ويلزم منه منع جواز إطلاق القبح على أفعال الله
تعالى لعدم وروده على لسان الشرع المنقول وعدم تأثير مخالفته لأغراض أصحاب
العقول
ثم كيف السبيل إلى جحد انتفاء الغرض عن أفعاله مع وقوع ما
بيناه من الأفعال التى لا غرض فيها وما قيل من أن فائدة خلق الحادثات
المعدنيات وغيرها إنما هو انتظام حال نوع الانسان والاستدلال بها على وجوب
وجوده وعظم جلاله في وحدانيته فلا يصلح أن يكون غرضا وإلا لوجب حصوله من
كل وجه على نحو لا يختلف من وجه ما و الا عد عاجزا عن تحصيل غرضه من ذلك
الوجه
ولم كان هلاكه لما خلق لأجل صلاحه وانتظام أحواله وذلك كما في
حق الغرقى والحرقى والمسمومين والهلكى بالرياح العاصفة كما مضى فيمن هلك
من الأمم السالفة بل وكم من تارك النظر في الآيات والدلائل الباهرات ولم
يلتفت إلى ما فيها من جهات الاستدلالات ولهذا لو نسبنا الناظر المؤمن إلى
الجاحد الكافر لم يجده إلا قليلا من كثير ثم لا محالة أن فائدة الاطلاع
على وجوب وجود واجب الوجود ومعرفة وحدانيته لا سبيل إلى القول بعودها إليه
إذ هو يتعالى ويتقدس عن الأغراض كما سبق فلا بد وأن يعود إلى الناظر وتلك
الفائدة عند البحث عنها لا تخرج عن الالتذاذ بنفس المعرفة والثواب عليها
وذلك كله مقدور أن يحصله الله تعالى للعبد من غير واسطة بأن يخلق له العلم
بديا بمعرفته وأن ينيله الثواب الجزيل بدون النظر إلى نظره وطاعته وعلى
هذا يخرج القول بوجوب التكليف أيضا
ولا يصح أن يقال إن الثواب على
النظر والمشاق اللازمة بالفكر والتزام الطاعات بفعل المأمورات واجتناب
المنهيات ألذ من أن يكون بديا لانتفاء المنة والامتنان فإنا نلوذ بجناب
الجبروت ونستعيذ بعظمة الملكوت ممن يتجاسر على
الإفصاح بهذا
الافتضاح ويتفوه بالتكبر على الله تعالى والتجنب من الدخول في منته
والإشتمال بنعمته و كيف السبيل إلى الخروج عن ذلك وأين المفر منه وهل أصاب
إيجاده مبرأ من الآفات ممكنا من اللذات أو خلق ما يصدر عنه من الطاعات
وأنواع العبادات إلا بفضل من الله تعالى بديا من غير سابقة طاعة أو فعل
عبادة وهل نعمه السابقة إلينا المشتملة علينا مما يمكن القول بعدها أو
التعرض لحصرها
ثم إن الخصم معترف بأن ما يفعله العبد من الطاعات
واجب عليه وملجأ إليه شكرا منه لله تعالى على ما أولى من مننه وأسبغ من
جزيل نعمه فكيف يستحق الثواب على ما أدى من الواجبات والجزاء على ما حتم
عليه من الطاعات وانواع العبادات
أم كيف السبيل إلى الجمع بين القول
بوجوب الطاعة على العبد شكرا والثواب على البارى جزاء وهل ذاك إلا دور
ممتنع من جهة أن الشكر لا يجب إلا بعد سابقة الثواب المتطول به لا ما وقع
بطريق الوجوب فإن ذلك لا يستحق شكرا والجزاء الواجب لا يكون إلا بعد سابقة
خدمة وطاعة متبرع بها لا ما وقع بطريق الإيجاب
وقوله تعالى ولتجزى
كل نفس بما كسبت وقوله ليجزى الذي أسئوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا
بالحسنى فليس المراد بها التعليل وإنما المراد بها
تعريف الحال
في المآل كما في قوله تعالى فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقوله
ومن رحتمه جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله وعلى هذا
يخرج كل ما ورد في هذا الباب من الآيات والدلالات السمعيات ونحن لا ننكر
أن ذلك مما يقع وانما ننكر كونه مقصودا بالتكليفات والأمر بالطاعات حتى
يقال إنه خلق لكذا أو لعلة كذا بل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
بل
ويكفى الخصم من سخف عقله وزيف رأيه أن عادت حكمة خلق السموات والأرض
والنجوم والشجر والجبال وإظهال الآيات والدلائل والمعجزات وإيجاب الطاعات
والعبادات وتصريف الخلائق بين المأمورات والمنهيات إلى لذة يجدها بعض
المخلوقين في مقابلة طاعته تزيد على اللذة التى يجدها بطريق الابتداء
والتفضل مع أن الله تعالى قادر على أن يخلق له أضعاف تلك اللذة في التفضل
الابتدائى من غير تعب ولا نصب إن الله على كل شئ قدير
ثم الذى يقطع
به دابر العناد ويخمد ثائرة الإلحاد التزام خلود أهل النار في النار
بكبيرة واحدة إذا ماتوا قبل الإقلاع عنها والتوبة منهما وما قيل من أن ذلك
هو الأصلح لهم لعلمه بهم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فغير مفيد مع
العلم بقدرة الله تعالى على منعهم منها وإماتتهم قبل الوصول إليها
وإقدارهم على التوبة قبل الأوبة فما الفائدة في تمكينهم من الكفران
وإقدارهم على العصيان ومنعهم من التوبة ولقد كان قادرا على التجاوز
والامتنان والصفح عنه والغفران فلو فعل ذلك لقد
كان أليق بحكمته
وأقرب إلى رأفته من أن يعذبهم بالنيران ويحرمهم نعيم الجنان فإنا قد وجدنا
المديح للغافر لا سيما في حق من لا يتضرر بالغفران ولا ينتفع بالانتقام بل
هما بالنسة إلى جلال عظمته وقدوس صمديته سيان فما باله استأثر بالأنتقام
على الإنعام بالغفران وبالعقاب على الامتنان
بل لا يحسن في العقل في
معرض المجازاة مقابلة معصية واحدة بالخلود في العذاب المقيم الأبدى
السرمدى بل لو قيل إن العقل يقبح ذلك لقد كان هو الأليق فانظر إلى هؤلاء
كيف تخبطوا في الحقائق لقصور أفهامهم وضلوا في ظلمات أوهامهم واشكر الله
على ما منحك مما حرم منع غيرك إن الله يجزى الشاكرين
وما هول به من
أن انتفاء الحكمة غير لازم من عدم تعلق العلم بوجودها فصحيح لكن المدعى
ههنا إنما هو تعلق العلم بعدمها على ما شهد به العقل الصريح وفرق بين عدم
تعلق العلم بوجود الشئ وبين تعلق العلم بعدم الشئ إذ الوجود مع الأول
متصور ومع الثانى ممتنع
فقد تحقق من هذه الجمل أن الغرض والصلاح
ووجوب رعايته ممتنع في حق واجب الوجود والذى يشهد بذلك ويؤكده ما أسلفناه
من الإلزامات وقدمناه من الإشكالات في اعتبار إيجاب النوافل واعتبار إيجاب
رعاية الصلاح والأصلح في الشاهد وما ذكروه من الفرق فهو يرجع على قاعدتهم
في إيجاب الطاعة والشكر على العبيد بالإبطال وإن نظر إلى ما يستحقه من
الثواب في مقابلته فهو باطل لما أثبتناه ومع بطلانه فلم لا قيل به في محل
الإلزام وما الفرق بين الصورتين وما الفاصل
بين الحالين وهل ذلك إلا محض خيال لا أصل له ومجرد استرسال لا
سند له نعوذ بالله من الشيطان والتخبط في الأديان
وما قيل من أن مستند ذلك ليس إلا نفى العبث والقبح عن أفعال واجب الوجود
فمبنى على أصلهم في التحسين والتقبيح وقد أوضحنا فساده
وما قيل في تقرير الأصلح مما لا ثبوت له على محك النظر ولا مقر له في
ميدان العبر فإنه ما من أمر يقدر أن الانسان سيطغى عنه إلا والرب تعالى
قادر على أن يعصمه منه ويمنعه عنه وإذ ذاك فلا يطغى واعتبار الأصلح في حقه
يكون أولى كيف وأن هذا ينقض قاعدتهم في التكليف رعاية لمصلحة العبد مع
العلم بأنه يكفر ويفجر
فإذا يمتنع رعاية الأصلح نفيا للطغيان ويمتنع
التكليف رعاية لدفع الكفران وهو مما يعسر دفعه على الخصوم ويصعب حله على
أرباب الفهوم وإذا ثبت ما مهدناه لزم القول بانتفاء الوجوب عن جميع أفعال
واجب الوجود لما سبق
ولا يروعنك تفسير وجوب فعل الله تعالى بلزوم
الظلم والعبث عليه بفرض عدمه كما في الثواب على الطاعة وإيلام الحيوان
البرئ فإن ذلك يستدعى بيان قبوليته لأن يتصف بالظلم والعبث وكل ما يوجب له
في ذاته نقصا وذلك مما لا سبيل إليه بل الظلم وكل صفة منقصة مسلوبة عنه
لامتناع اتصافه بها وذلك على نحو سلب الظلم والعبث عن الحيوانات والجمادات
وغير ذلك من النباتات إذ الظلم يتصور ممن يصادف
تصرفه ملك غيره من غير علمه أو مخالفة من هو داخل تحت تصرفه
وحكمه وذلك كله منفى عن البارى تعالى
ثم إن ذلك مبنى على أصولهم في التحسين والتقبيح وقد أبطلناه ثم كيف السبيل
إلى تفسير الواجب في حقه بما يلزم من فرض عدمه المحال مع ما أسلفناه من
قصة أبى جهل وتكليف غيره ممن مات على كفره بالإيمان ومجرد الإمكان غير كاف
في التمكين إلا مع القدرة عليه والاسترسال بكونه مقدورا له قبل الفعل مع
ما عرف من أصلنا في الاستطاعة وانها لا تكون إلا مع الفعل غير مفيد ثم ولو
كان مقدورا فلا بد وأن يكون وقوعه بالفعل متصورا ولو تصور وقوعه بالفعل
لانقلب العلم السابق جهلا وذلك محال في حق البارى تعالى لما سلف وامتناع
وقوع المحال لا فرق فيه بين أن يكون لازما عن الشئ باعتبار ذاته وبين أن
يكون لازما عنه باعتبار غيره فيما يرجع إلى نفس المقصود وهو الوقوع ومن
جحد ذلك فليسل الله تعالى أن يرزقه عقلا
ومن أنكر حلول الآلام
بالحيوان وإلمامه بها فجحده لبديهيته يغنى عن مكالمته ولسانه ينادى على
نفسه بفضيحته فإن ذلك غير متقاصر عن جحد كونها حية ومتحركة وغير ذلك مما
لها من الصفات المحسوسة ومن زعم أن ذلك قبيح لعينه فقد تبين فساد أصله في
التحسن والتقبيح ثم ولو كان كذلك للزم أن من شرب دواء كرها أو احتجم أو
انفصد أملا لإزالة داء ممرض أن يعد ذلك منه قبيحا على نحو ما إذا ألقى
نفسه في تهلكة وهو خلاف المعقول
وأما الثنوية فقد أبطلنا عليهم قواعدهم والتناسخية فسنبين فيما يأتى زيف
عقائدهم إن شاء الله تعالى وهو الهادى لطرق الرشاد
القاعدة الثالثة
في حدوث المخلوقات وقطع تسلسل الكائناتوقد اضطربت فيه الآراء واختلف فيه الأهواء
فذهبت طوائف من الإلهيين كالرواقيين والمشائيين ومن تابعهم من فلاسفة الإسلاميين إلى القول بوجوب ما وجب عن الواجب بذاته مع وجوده وإن قيل له حادث فليس إلا بمعنى أن وجوب وجوده لغيره وأن له مبدأ يستند إليه ويتقدم عليه تقدما بالذات على نحو تقدم العلل والمعلولات لا بمعنى أن حدوثه من عدم بل هو أزلى أبدى لم يزل ولا يزال وكذلك حكم ما وجب عما وجب وجوده بالواجب بذاته وهلم جرا على ما ذكرناه من تفصيل مذاهبهم وإيضاح قواعدهم فيما لا يقبل الفساد كالأجرام الفلكية ونفوسها والعقول التى هى مبادئ لها فهى قديمة أزلية لم تزل ولا تزال
وما هو قابل للاستحالة كالحركات وامتزاجات أو الفساد كالصور الجوهرية للعناصر والمركبات فهى وإن كان كل واحد منها حادثا لكنه لا أول لها ينتهى إليه بل هى لا تتناهى مدة ولا عدة وما من كائن فاسد إلا وقبله كائن آخر إلى مال يتناهى ولم يوجبوا التناهى على أصلهم إلا فما له ترتيب وضعى كالامتدادات أو ترتيب طبيعى وآحاده موجوده معا كالعلل والمعلولات وأما ما سواه فالحكم بأن
لا نهاية له غير مستحيل كالحركات الدورية والنفوس الإنسانة بعد
المفارقة للأجرام البدنية كما سلف
وذهب أهل الحق من الإسلاميين وغيرهم من أهل الشرائع الماضين وجماعة من
الحكماء المتقدمين إلى أن كل موجود سوى الواجب بذاته فموجود بعد العدم
وكائن بعد أن لم يكن وأن الحكم له بالمعية مع الواجب الأبدية واللازم
للسرمدية مما لا سبيل أليه ولا معول لأرباب العقول عليه بل البارى تعالى
كائن ولا كائن ومتقدم بالوجود ولا موجود وأن ما أبدعه لم يكن معه بل هو
المنفرد بالأبدية المتوحد بالسرمدية خالق الخلق بعد العدم ومعيدهم بعد
الرمم إن الله على كل شئ قدير
وعند هذا فلا بد من البحث عن مطمح نظر الفريقين والكشف عن مقصد الطائفتين
ولتكن البداية بتقديم النظر في طرق أهل الحق أولا وإبطال شبه أهل الضلال
والانفصال عنها ثانيا
والكلام في هذه المسألة يقع في طرفين
أ طرف في إبطال القول بلزوم القدم
ب وطرف في إثبات الحدوث بعد العدم
أما الطرف الأول
فقد سلك المتكلوم فيه بيان افتقار العالم إلى صانع مبدع أولا ثم بيان إبطال الإيجاد بالذات ثانيا فقال بعضهم في بيان وجه الافتقار إلى الصانع المبدعإنا لو قدرنا قدم الجواهر فليس تخلو عن اجتماع وافتراق إذ لا جائز أن تكون لا مجتمعة و لا مفترقة وعلى كل تقدير فنحن نعلم جواز تبدل الاجتماع والافتراق عليها وعند ذلك فلا تخلو إما أن تكون مستحقة لذلك لذواتها أو باعتبار أمر خارج لا جائز أن تكون مستحقة لذلك لذواتها فإن ما ثبت للذات يدوم بدوام الذات ولا يتصور عليه التبدل أصلا فإذا لا بد أن يكون المخصص لها بذلك أمرا خارجا لا محالة
واعلم أن التعرض لإظهار هذا المقدار ليس بمفيد لأن الخصم ما يدفعه أو يمنعه وإنما هو لإسناد العلم به إلى الدليل ولدفع شغب معاند مجاحد خارج عن هذا القبيل فإذا كان كذلك فالعلم بصحة مدلول هذا الدليل يتوقف على حصر الجواهر والموجودات فيما هو قابل للاجتماع والافتراق إذ ربما يقول الخصم بوجود جواهر مجردة عن المادة وعلائق المواد لا تقبل الاجتماع والافتراق ولا يصح القول بكونها مجتمعة ولا متفرقة لكونها عقولا محضة
وذلك أيضا مما لا يكفى بل لابد من بيان
أن ما حصل بين الجواهر أو بعضها من الاجتماع أو الافتراق مما لا تقتضيه
بذواتها إذ ربما لا يسلمه الخصم عنادا بالنسبة إلى بعض الجواهر كالاجتماع
الكائن بين الأجرام الفلكية والجواهر العلوية وكذلك بعض الافتراقات لبعض
الأجرام أيضا فمجرد الدعوى في ذلك غير كافية ولا شافية
وليس يلزم من
جواز تبدل الاجتماع والافتراق على بعض الجواهر السفلية مثله في الجواهر
العلوية ولا كذلك بالعكس لما اشتركا فيه من الجوهرية أو الجسمية فإنه لا
مانع من أن يكون ذلك لها باعتبار خصوصياتها ولما وقع به الافتراق بين
ذواتها
وإن أمكن بيان ذلك فهو مما يطول ويصعب تحقيقه جدا على أرباب العقول
ولهذا انتهج إمام الحرمين هذا المنهج بعبارة أخرى فقال
نعلم قطعا أن اختصاص العالم بشكله المقدر مع جواز أن يكون أصغر من ذلك أو
أكبر وفرضه في مستقره من غير تيامن ولا تياسر واختصاص كل جزء من أجزائه
بمكانه من المحيط إلى المركز بحيث كانت الأفلاك محيطة بالنار والنار محيط
بالهواء والهواء بالماء والماء بالتراب إلى غير ذلك من وجوه التخصيصات مما
لا يستحيل القول بفرض وجود تلك الأجرام بذواتها مع غيرها كأن يكون العالم
أصغر أو أكبر مما هو عليه أو متيامنا أو متياسرا مما هو عليه من مستقره
أيضا ولو كان ذلك مما يثبت لها باعتبار
ذواتها لما تصور فرض
تبدله أصلا فإذا اختصاصها به إنما هو باعتبار مخصص خارج وما لزم الأول في
قضيته فهو أيضا لازم لهذا القائل على طريقته مع لزوم بيان تناهى الأبعاد
وفرض خلاء وراء العالم لضرورة صحة فرض التباين والتياسر
ولأجل ذلك
فر بعض المحققين في ذلك إلى بيان جهة الإمكان فقال القسمة العقلية حصرت
المعلومات في ثلاثة أقسام واجب لذاته وممتنع لذاته وممكن لذاته فالواجب هو
الموجود الذى لو فرض معدوما لزم عنه المحال لذاته والممتنع لو فرض موجودا
لزم عنه لذاته المحال والممكن هو ما لو فرض موجودا أو معدوما لم يعرض عنه
محال
فالعالم إما أن يكون واجبا أو ممتنعا أو ممكنا لا جائز أن يكون
واجبا لأن أجزائه متغيرة عيانا وضرورى الوجود لا يتغير بحال ولا جائز أن
يكون ممتنعا وإلا لما وجد فتعين أن يكون لذاته ممكنا وكل ممكن فترجحه في
جانب وجوده أو عدمه ليس إلا بغيره وإلا كان واجبا ممتنعا فترجح العالم في
جانب وجوده ليس ألا بغيره
ثم نظم لذلك قياسا مركبا منفصلا فقال
العالم متغير ومتكثر وكل متكثر ومتغير فهو ممكن الوجود بذاته وكل ممكن
الوجود بذاته فوجوده بإيجاد غيره فوجود العالم بإيجاد غيره وذلك الغير
يستحيل أن يكون مرجحا بذاته لثلاثة أوجه
الوجه الأول أن الوجود
والذات لا اختلاف فيهما بين موجود وموجود وهما في الواجب والجائز بمعنى
واحد فلو أوجب الوجود من حيث إنه ذات ووجود لم يكن إيجاده لغيره بذلك
الاعتبار بأولى من وجوده هو بغيره بناء على ما اشتركا فيه من ذلك الاعتبار
الوجه الثانى هو أن الجائزات بأسرها متماثلة من حيث هى جائزة وهى لم
تكن مفتقرة إلى المرجح إلا من حيث ما وقع بينها من الاشتراك في جهة
الإمكان والموجب بالذات لا يخصص مثلا عن مثل إذ نسبة سائر المتماثلات إليه
على وتيرة واحدة
والوجه الثالث هو أن الواجب بذاته مهما لم يكن بينه
وبين الموجب مناسبة أو تعلق ما بل انفرد كل واحد بحقيقته وخاصيته لم يقض
العقل بصدور أحدهما عن الآخر أصلا ولا محالة أن البارى تعالى منفرد
بحقيقته عن جميع المناسبات والتعلقات فإيجاده لغيره بالذات لا يكون معقولا
فإذا قد امتنع الإيجاد بالذات وتعين أن يكون بصفة زائدة بها التخصيص وهى
المعنى بالإرادة ومع ذلك فلا يلزم القول بلزوم القدم
ولربما قرر بتقرير آخر وهو أن العالم ممكن والممكن جائز الوجود
وجائز
العدم لا جائز الوجوب وجائز الامتناع فاستفادته من المرجح ليس إلا وجوده
لا وجوبه إذ الوجوب عارض للوجود ولهذا يصح أن يقال وجد فوجب ولا يصح أن
يقال وجب فوجد وإذا كان الوجوب عارضا للوجود فالمستند إلى المرجح إنما هو
الوجود لا ما عرض له فعلى هذا إذا قيل إن الممكن وجد بإيجاد غيره كان
مستقيما لفظا ومعنى وإذا قيل إنه وجب بايجاب بغيره كان مختلا لفظا ومعنى
وإذا بطل أن يكون المستفاد من المرجح هو الوجوب بطل الإيجاب الذاتى
للملاءمة بين وجود المفيد والمستفيد
ولقد فر مما لا طاقة له به إلى
ما لا قبل له به وذلك أنه إن أراد بالتغير التغير في كل أجزاء عالم الكون
والفساد والتبدل بالوجود بعد العدم والعدم وبعد الوجود فذلك مما لا سبيل
إلى ادعائه غائبا بطريق العموم والشمول وإن صح ذلك في بعض الجواهر الصورية
وبعض الأمور العرضية ومع امتناع إسناد ذلك إلى العيان لا بد فيه من البيان
وإن أراد به التغير في أحوال الموجودات وما يتعلق بها من التغيرات
فقد التزم في ذلك ما فر منه أولا وهو بيان انتفاء موجود لا يقبل التغير
أصلا وذلك كما أثبته الخصم من العقول الكروبية والنفوس الروحانية وبيان
وجود الأعراض وحدثها وانتهائها وامتناع عرو الجواهر عنها حتى يصح القول
بحدث الجواهر بأصلها وكونها ممكنة الوجود في نفسها وإلا فلا يلزم من قيام
شئ متغير بشئ أن يكون ذلك الشئ في نفسه متغيرا وإذا لم يكن متغيرا فقد
انتفى عنه ما جعله مستندا
لبيان الإمكان أولا وعند ذلك فلا يلزم أن يكون العالم بجميع
أجزائه ممكنا على ما لا يخفى
وما قيل من أن الوجود بالذات في الواجب والجائز بمعنى واحد وليس إيجاب
أحدهما للآخر بأولى من العكس فمما لا سبيل إليه على الرأيين وذلك أنه لو
كان معنى الذات والوجود فيهما معنى واحدا للزم أن تكون ذات واجب الوجود
ووجوده ممكنا او أن يكون وجود الجائز وذاته واجبا لضرورة الاشتراك فيما
قيل إنه واجب في أحدهما وممكن في الآخر فإن ما ثبت لشئ لنفسه كان لازما له
مهما وجد وإن اختلفت الجهات والمتعلقات ولا يخفى أن جعل الواجب بذاته
ممكنا أو الممكن واجبا من أمحل المحالات إذ الواجب لذاته ما لو فرض معدوما
عرض عنه المحال لذاته والممكن ما لا يعرض المحال لذاته لا من فرض وجوده
ولا عدمه فإذا ليس الاشتراك بين الوجب والجائز في غير اسم الوجود والذات
والاشترك في الاسم مع اختلاف الحقيقة لا يوجب الأولوية لعدم ارتباط
الإيجاد والإحداث بما وقع به الاشتراك من الاسم
وما قيل من أن
الجائزات بأسرها متماثلة ومتساوية بالنسبة إلى الموجود بالذات فتوسع في
الدعوى وذلك أن الخصم وإن سلم أن وجود الجائزات متساو بالنسبة إلى ذات
الممكن بحيث لو اتصف بأى منهما كان لم يكن ذلك لاختصاصه بمخصص من الذات
القابلة له بل هى بالنسبة اليه و إلى غيره على السواء فليس يسلم تساويهما
بالنسبة إلى المخصص لا سيما إن كان مقتضيا لذلك بالذات والطبع وذلك لأنه
إذا كان المخصص مخصصا بالذات وكان له صلاحية تخصيص جميع الجائزات من
الوجود
والعدم من غير أولوية لأحدهما فهو إما أن يكون مخصصا لكل
واحد من جهة ما خصص الآخر منهما فهو محال إذ المخصصات المختلفة مستحيل أن
تستند في جانب مخصصها إلى شئ واحد من كل جهة وإن كان ذلك باعتبار جهات فلا
يكون الاقتضاء بالذات ولا يكون مستند سائر الممكنات إلى مجرد الذات قضية
واحدة بل الذات لا تكون مقتضية إلا لشئ واحد إن اقتضت غيره فليس إلا
باعتبار صفات زائدة عليها فإذا لفظ الإيجاب بالذات يلازمه نفى الاشتراك
فيه والتساوى في نسبة الموجبات المختلفة إليه فالقول بوجوب التساوى إذ ذاك
تناقض
والذى يوضح مأخذ هذا المنع ما اشتهر من معتقد الخصم من أن
نسبة إيجاد البارى تعالى لما أوجده بذاته كنسبة إيجاب حركة اليد لحركة
الخاتم ولا يخفى أنه وإن كانت حركة الخاتم وسكونها بالنسبة الى ذات الخاتم
سيان فليس يلزم أن يكون سكون الخاتم وحركتها بالنسبة إلى حركة اليد سيان
بل العقل يقضى باستحالة سكون الخاتم مع حركة اليد ووجوب حركتها عند حركة
اليد
وأما ادعاء المناسبة ووجوب التعلق بين الموجب بالذات وما أوجبه
إن أريد به أن يكون كل واحد منهما على حقيقته بحيث يلزم من وجود أحدهما
وجود الآخر فذلك مما لا نزاع فيه وإنما الشأن بيان أنه لم يثبت للبارى
تعالى ولما أوجبه الحقيقة التى يكون بها أحدهما علة والآخر معلولا ولا
يخفى ما فيه من التعسف وإن أريد بالمناسبة المساواة والمشابهة في أمر ما
فذلك أيضا تحكم غير مقبول ثم كيف يمكن القول بذلك ولو وقع لم يخل إما أن
يكون الإيجاب باعتباره أو باعتبار ما وقع الاختلاف فيه بين حقيقة الموجب
والموجب فإن كان باعتباره فليس جعل أحدهما عله للآخر بأولى من العكس
لضرورة التساوى بينهما في ذلك المعنى وإن كان باعتبار ما وقع به الاختلاف
فلا حاجة إلى القول بالمشابهة ولا المساواة في شئ ما
وما قيل من
أن المستفيد ليس له من المفيد غير الوجود وأما الوجوب فعارض وتابع للوجود
فلا يوجب مقارنة وجود المستفيد لوجود مفيده فهو يشعر بعدم الإحاطة بمقصود
الخصم من قوله العالم واجب الوجود للواجب بذاته ومنشأ ذلك إنما هو اختلاف
جهات حقيقة الوجوب مع اتحاد لفظ الوجوب فإن وجوب الوجود منه ما هو ثابت
لذات الوجود وهو غير مراد فيما نحن فيه ومنه ما هو مشروط بأمر خارج عن
الذات ثم ذلك منه ما هو مشروط بنفس الوجود كقولنا زيد واجب الوجود فى حالة
كونه موجودا ومنه ما هو مشروط بما هو متعلق علة الوجود في العقل كما في
قولنا بوجوب وجود المعلول بالنظر إلى علته ويكون معنى كون أنه واجب الوجود
بالنظر إلى علته أنه لو فرض معدوما عند وجود علته لزم المحال
ولا
يخفى أن الوجوب بالاعتبار الأول تابع للوجود ولا يصح أن يقال بذلك
الاعتبار إنه وجب فوجب بل وجد فوجب وأما الوجوب بالإعتبار الثانى فإنه لا
محالة متعلق علة الوجود فإنه يصح أن نقول وإن قطعنا النظر عن الموجود إنه
واجب الوجود بمعنى أنه يلزم من فرض عدمه لوجود علته المحال وعلى هذا
الاعتبار يصح أن يقال أنه وجب فوجد أى لما لزم المحال من فرض عدمه عند
وجود علته وجد ولا يصح أن يقال وجد فوجب إذ يلزم المحال من فرض عدمه لوجود
علته
وعلى هذا إن أريد بمتابعة الوجوب للوجود ما هو بالاعتبار الأول
فلا خفاء بصحته لكنه مما لا يفيد إذ هو غير مراد للخصم وإن أريد به
الاعتبار الثانى فلا خفاء بفساده ولا يخفى أن ذلك مما يوجب الملازمة بين
الوجودين والمعية بين الذاتين إذ يستحيل أن يقال إنه يلزم المحال من فرض
عدمه مهما وجدت علته مع جواز فرض تأخره عنها وليس المعنى بكونه واجبا
بالواجب بذاته إلا هذا ولا سبيل إلى مدافعته
وليس من السديد ما قيل في معرض الإلزام للخصم وإبطال القول
بالقدم
إنك موافق على تسمية البارى فاعلا والعالم حادثا فلو كان وجود العالم
ملازما لوجود البارى تعالى ملازمة لا يمكن القول بدفعها كملازمة الظل
للشجرة والمعلول للعلة لامتنع تسميته فاعلا كما يمتنع تسمية الشجرة فاعلة
للظل والعلة فاعلة للملعول من جهة أن الفاعل عبارة عمن يصدر منه الفعل مع
الإرادة للفعل وعلى سبيل الاختيار وأيضا لامتنع تسمية العالم حادثا إذ
الحادث هو ما له أول ووجوده بعد ما لم يكن
فإن الخصم إنما يعنى بكون
البارى فاعلا للعالم أن وجوده لازم لوجوده لا غير وذلك إن لم يوافق الوضع
اللغوى فلا يرجع حاصل السؤال إلا إلى مناقشة لفظية ومجادلة قولية ولا
اعتبار به وتسمية العالم حادثا إنما هو عنده بمعنى أنه في جانب وجوده
مفتقر إلى غيره وإن لم يكن له أول ومعنى كونه قديما أنه لا أول لوجوده إذ
القديم قد يطلق عنده على ما لا أول لوجوده وإن كان وجوده مفتقرا إلى غيره
وقد يطلق على ما لا يفتقر في وجوده إلى غيره كما سبق من أن تسمية العالم
قديما ومحدثا إنما هو باعتبارين مختلفين ولا مشاحة في الإطلاقات بعد فهم
غور المعنى
ولا يلزم على هذا أن يقال إذا كان العالم لا أول لوجوده
امتنع القول بإيجاده بغيره إذ لقول بإيجاد الموجود محال فإن من حقق مواقع
الإجماع من إيجاد
الحادثات بعد العدم سلم أنه لا أثر في الإيجاد
لسبق العدم فإن ايجاد الموجد له إما أن يتعلق به في حال وجوده أو في حالة
عدمه أو في الحالتين جميعا لا جائز أن يكون متعلقا به في حال عدمه إذ هو
المحال وبه نفس فساد القسم الثالث أيضا فبقى أن يكون متعلق به في حال
وجوده فإنه لو قطع النظر في تلك الحالة عن الموجد لما وجد المعلول وليس
استناد الموجد إلى الموجد من جهة وجوده حتى يطرد ذلك في كل موجود بل
الصحيح أن إسناده إليه ليس إلا من جهة إمكانه وذلك وإن استدعى سبق الإمكان
على الوجود بالذات فهو لا يستدعى سبق العلة أصلا
ثم ولو قيل إنه
مستند إلى الموجد من حيث وجوده فإنما يلزم القول بالاطراد أن لو وقع القول
بالاشتراك بين الموجودات في مسمى الوجود لا في مجرد التسمية كما بيناه من
قبل
فإذا القول بإبطال لزوم القدم إنما يلزم أن لو جاز صدور العالم
عما صدر عنه بجهة القدرة والإرادة ولا يخفى جواز ذلك لضرورة كون البارى
قادرا مريدا كما أسلفناه كيف وسنبين اندراجه في طرف سبق العدم بطريقة
جامعة بينهما وسبيل واحد موصل إليهما من غير احتياج إلى تخصيص دليل بكل
واحد منهما
الطرف الثانى
في اثبات الحدوث بعد العدمولقد سلك بعض المتأخرين هو محمد الشهرستانى في ذلك طريقة ظن أنه ممن حاز بها قصب سبق المتقدمين فقال في معرض الحكاية عن القوم في أقسام التقدم والتأخر ومعا
أن التقدم قد يطلق ويراد به التقدم بالزمان كتقدم آدم على إبراهيم وقد يطلق ويراد به التقدم بالشرف كتقدم العالم على الجاهل وقد يطلق ويراد به التقدم بالرتبة كتقدم الإمام على الصف في جهة المحراب إن جعل مبدأ وقد يطلق ويراد به التقدم بالطبع كتقدم الواحد على الاثنين وقد يطلق ويراد به التقدم بالعلية كتقدم الشمس على ضوئها وتقدم حركة اليد على حركة الخاتم ونحوه
ثم زعم أن هذه الأقسام مما لا دليل على حصرها ولا ضبط لعددها حتى إنه زاد قسما سادسا وهو التقدم بالوجود من غير التفات إلى الزمان أو المكان أو الشرف أو الطبع أو العلية فقال لا يبعد تصور شيئين وجود أحدهما لذاته ووجود الآخر من غيره ثم ننظر بعد ذلك هل استفاد وجوده منه طبعا أو ذاتا أو غير ذلك وعلى هذا النحو أقسام التأخر ومعا ثم قال إن المعية من كل رتبة لا تجامع التقدم والتأخر
من تلك الرتبة بحيث تكون
نسبة أحد الشيئين إلى الآخر بالمعية والتقدم أو التأخر بالذات وإن جاز أن
تكون المعية من رتبتها مجامعة للتقدم والتأخر من رتبة أخرى كالمعية بالشرف
والتقدم بالزمان ونحوه ثم بين ذلك وحكى ما قرر من بيان إمكانه العالم
باعتبار ذاته وافتقاره إلى مرجح خارج ووجوب تقدم المرجح عليه ذاتا ووجودا
وامتناع تحقق المعية بكل حال بينهما فقال
إذا ثبت أن العالم مفتقر
في جانب وجوده إلى مرجح وجب أن نفرض المفيد له متقدما على وجوده ذاتا
ووجودا إذ المفيد مستحيل أن يقارن وجوده وجود المستفيد من حيث هما كذلك
وان قدرت المقارنة بينهما في الوجود كما في حركة اليد مع حركة الخاتم فليس
يتصور إلا أن يكونا قد أخذا وجودهما عن امر خارج عنهما لا أن يكون أحدهما
سببا والآخر مسببا وإذا كان المفيد له سابقا عليه ذاتا ووجودا فيستحيل أن
يكون معه بالوجود والذات إذ قد بان أن المعية من كل رتبة لا تجامع التقدم
ولا التأخر من رتبتها بالنظر إلى جهة واحدة ولا جائز أن يكون معه بالزمان
ولا المكان والا كان وجود البارى زمانيا ومكانيا إذ المعية من جهة
المضافات كالأخوة والأبوة وإن كان أحد الشيئين مع الآخر بالأخوة كان الآخر
معه بها ولا يجوز أن يكون معه بالفضيلة والشرف إذ كيف يكون الناقص المفتقر
إلى غيره في وجوده مساويا في الفضيلة لما وجوده بذاته غير مفتقر إلى غيره
وكذا لا جائز أن يكون معه بالطبع والا كان وجوده مقارنا لوجوده وقد فرض
مقدما فإذا قد لزم القول بالتقدم وانتفاء المعية بكل حال وثبت أن البارى
كان ولم يكن معه شئ وأن كل ما أوجده فلا يكون إلا عن سبق عدم عليه
ولربما اورد في سياق كلامه ما يشعر بزيادة تقرير لهذا المعنى وهو أن
العالم إذا كان ممكنا باعتبار ذاته فالوجود له عرض مأخوذ من الغير والعدم
له ذاتى مأخوذ من ذاته وما هو ذاتى للشئ يكون سابقا على ما هو عرضى
بالنسبة اليه فالعالم إذا في وجوده مسبوق بموجود هو واجب الوجود بذاته
وتقدمه هو ثابت لذاته وما له أول والعدم سابق على وجوده سبقا ذاتيا كيف
يكون وجوده مع وجود ما لا أول لوجوده ولا عدم يسبقه
وهذا جملة ما أورده متفرقا في غضون كلامه لكنا كسوناه ترتيبا
وزدناه إلى الفهم تقريبا وهو عند التحقيق سراب غير حقيق
وذلك أن ما ذكره من القسم السادس الزائد على أقسام التقدم والتأخر ومعا
وان كان الحق على مذهب أهل الحق لكنه مما لا نفع فيه بمجرد المقال ومحض
الاسترسال إذ ربما يقول الخصم إن ذلك ليس بزائد على الأقسام المذكروة
والمراتب المحصورة بل هو داخل فيها وذلك أن ما فرض متقدما بوجوده إما أن
يكون بينه وبين المتأخر عنه مدة يمكن وجود ثالث بينهما فهو المتقدم
بالزمان وان لم تكن بينهما مثل هذه المدة فإما أن يفتقر إليه المتأخر في
وجوده أم لا يفتقر فإن لم يفتقر فالتقدم والتأخر بينهما اما بنسبة الى امر
يرجع اليهما او بالنسبة الى امر خارج عنهما فإن كان الأول فهو التقدم
بالفضيلة والشرف وان كان الثانى فهو التقدم بالرتبة والمكان وان كان
المتأخر مفتقرا إليه في وجوده فإما أن يصح أن يفرض بينهما مدة أو لا يصح
فإن كان الأول فالمتقدم متقدم بالطبع وان كان الثانى فهو المتقدم بالعلية
وما فرض متقدما بالوجود وبينه وبين المتأخر عنه مدة كالمدة المفروضة وإن
افتقر الخصم إلى بيان كونه متقدما بالزمان لضرورة الحصر في الخمسة الأقسام
فلا بد من بيان نفيه أيضا عند من زاد قسما سادسا وهو التقدم بالوجود
لضرورة صحته وإلا فكل واحد من الفريقين يتحكم بالدعوى
ثم ولو قدر
تسليم الخصم بجواز وقوع هذا القسم السادس مع تسليم افتقار العالم إلى مرجح
لوجوده على عدمه فليس يلزم من ذلك تسليم وجوب التقدم في الوجود وإن سلم
أنه لا بد من وجوب التقدم بأحد الأنحاء المذكورة بل له أن يقول إذا فرض
شيئان أحدهما مستفاد من الآخر فالواجب أن يفرض وجوب التقدم لأحدهما على
الآخر من غير تخصيص
بالوجود والزمان أو الذات ثم ننظر بعد ذلك
فإن كان بينهما مدة وجاز تأخر أحدهما عن الآخر قيل تقدم بالوجود والزمان
وان لم يكن بينهما مدة ولا يجوز تأخر أحدهما عن الآخر قيل إنه متقدم
بالعلة فقط وهما معا بالوجود وذلك كما في حركة الخاتم مع حركة اليد ونحوها
وعند ذلك فلا يلزم من كون العالم مفتقرا في وجوده إلى غيره أن يكون الغير
متقدما بالوجود ولا أولوية لإحدى الدعويين على الأخرى
وعند ذلك فلا
يلزم التناقض من القول بوجوب تقدم البارى تعالى على العالم بالعلية ومن
كونه معه في الوجود إذ هما من مرتبتين مختلفتين وإنما يلزم التناقض أن لو
قيل إنه سابق عليه بالوجود ومعه بالوجود وليس كذلك بل المعية عند الخصم
بين العالم والبارى تعالى إنما هى في رتبة الوجود دون غيره والتقدم إنما
هو في رتبة العلية دونه غيرها
وما قيل من أن الخلق مستحق العدم
باعتبار ذاته فغلط من قائله إذ لو استحق العدم لذاته لكان ممتنعا ولما
تصور وجوده ولا بغيره ولخرج عن كونه ممكنا بل كما أن الوجود ليس له لذاته
كذلك العدم ولا يكون أحدهما سابقا لكن قد يكون ما هو علة ومرجح للوجود
بوجوده هو علة ومرجح للعدم بعدمه فإن تحقق وجوده لزم الوجود وان تحقق عدمه
لزم العدم لا محالة
ومما اعتمد عليه أيضا في هذا الباب الجهابذة من
المتكلمين وفضلاء المقتدمين المسلك المشهور والطريق المذكور وهو أنهم
حصروا العالم في الجواهر والأعراض ثم قصدوا
لإثبات الحركة
والسكون أولا ثم لبيان حدثها ثانيا ثم لبيان تناهيها ثالثا ثم لبيان
امتناع عرو الجواهر عنها رابعا ثم بنوا على ذلك أن العالم لا يسبق الحوادث
وكل ما لا يسبق الحوادث حادث
وهذه الطريقة وإن أمكن فيها بيان وجود
الأعراض وكونها زائدة على الجواهر وإبطال القول بالكمون والانتقال فقد
يصعب بيان امتناع عرو جوهر عنها بل وقد يصعب بيان حدث كل ما لا يعرى
الجوهر عنه في وجوده من الحركات والسكنات وحدوث الحركة وان كان مسلما فليس
يلزم منه حدث ما بطل به من السكون بل من الجائز أن يقول الخصم بقدمه وأنه
لا أول له وفواته لا يدل على حدثه وان دل على انه لم يكن له ذلك لذاته
وقول القائل إن ما يثبت قدمه لو بطل لا فتقر إلى سبب إذ يستحيل أن يكون
ذلك له لذاته والا لما بطل وإذا افتقر إلى سبب فالسبب إما فاعل للعدم
بالقدرة أو ضد أو انقطاع لا جائز أن يكون بالقدرة إذ الفعل بالقدرة يستدعى
مقدورا والعدم ليس معنى فيستحيل أن يكون مقدورا ولا جائز أن يكون السبب هو
مانع فإنه إما قديم وإما حادث فإن كان قديما استحال أن يعدم في الآن ولا
يعدم في القدم وإن كان حادثا فليس ابطال ما كان بكونه أولى من إبطال كونه
عما كان ولا جائز أن يكون السبب هو فوات شرط فإنه إما حادث أو قديم لا
جائز أن يكون حادثا إذ الحادث لا يصلح شرطا للقديم وإن كان قديما فالكلام
في ذلك القديم كالكلام في الأول وهو يسلم للمحال وهو وان سومح في قوله
بكون الإعدام ليس بمقدور مع صحة النزاع فيه
فمن الجائز أن يكون
دوام السكون إلى حين وغاية يستند إلى إرادة قديمة اقتضت دوامه إلى ذلك
الحين وعند انقطاع تعلق الإرادة به انقطع دوامه وذل على نحو انقطاع سائر
الموجودات وإذ ذاك فلا تسلسل وليس يلزم من كونه متعلق الإرادة ومقتضى
القدرة أن يكون حادثا كما لا يلزم أن يكون قديما بل القدم والحدث إنما
يعرض لما هو متعلق الإرادة والقدرة بأمر خارج عنهما هذا كله إن سلم كون
السكون أمرا وجوديا ومعنى حقيقيا
وإلا فإن سلك القول بكونه أمرا
سلبيا ومعلوما عدميا فإنه لا معنى له إلا عدم الحركة ولا يلزم من القول
بإبطاله بوجود الحركة أن يكون هو حادثا بمعنى أن له أولا إذ الأولية لا
تتحقق إلا بعد الوجود وإن سلك ذلك لزم منه القول بسبق العدم على الوجود
والوجود على العدم إلى ما لا يتناهى وفيه القول بقدم الحادث قطعا وعند ذلك
فالطريقة تكون منصوبة لنقيض المأخوذ
وإن قيل بالوقوف على عدم لا
يلزم ثبوت الأولية له بسبب إبطاله بالوجود بعده لم يلزم القول بأن الحركة
الحادثة دالة على حدث السكون وليس المقصود غير الإنصاف وتجنب طرق الاعتساف
وإلا لما اهتممنا بالكشف عن هذه العورات ولا الإبانة عن هذه الغمرات وهو
إنما يعرفه الفطن الثبت الواعى لا الجاهل العنيد المتعامى
فإذا
الواجب فرض الدلالة في إثبات حدث الكائنات الفاسدات وما نجده على سبيل
الاستحالة كالأزمنة والحركات وغير ذلك من الأمور المتعاقبات والطريقة
الرشيقة في
إثبات حدثها وبيان وجودها بعد عدمها ما سلكناه في قطع
تسلسل العلل والمعلولات وقد سبق وجه تحقيقه فلا حاجة إلى إعادته واللازم
عن ذلك على معتقد الخصم حدث الأفلاك لضرورة الحدث والانتهاء لما قام بها
من الحركات وامتناع خلوها عنها عنده ويلزم من ذلك حدوث العقول التى هى
مبادئ الأفلاك عندهم وحدث المعلول الأول الصادر عن واجب الوجود لكون ما
وجد عنه وعنها حادثا وأن إيجادها لما وجد عنها ليس إلا بالذات وأن التقدم
والتأخر بينهما بغير هذه الرتبة من الممتنعات كما عرفنا من تفصيل مذهبهم
وأوضحناه من زيف معتقدهم
ويلزم من ذلك أن يكون وجود ما صدر عن واجب
الوجود اختياريا وإبداعيا لا واجبا إذ لو استند ذلك إلى ذات المرجح له لما
تأخر عن وجوده لتساوى أوقات الحدوث بالنسبة إليه
ولا يلزم على هذا
أن يقال ولو كان وجوده إراديا لما تأخر وجوده عن وجود الإرادة المخصصة له
لتساوى أوقات الحدوث بالنسبة إليها أيضا إذ هو يتضمن إبطال معنى الإرادة
إذ الأرادة على ما وقع عليه الاتفاق ليست إلا عبارة عن معنى يخصص الحادث
بزمان حدوثه فإن قيل إن نسبة سائر أوقات الحدوث إلى الإرادة على وتيرة
واحدة فلم خصصته بالبعض دون البعض كان معناه لم كانت الإرادة إرادة ولا
يخفى ما فيه من الغباوة والحمق والجهالة وليس هو إلا كما لو قيل الإنسان
مثلا حيوان ناطق فقيل ولم إذ ليس حاصله غير القول لم كان الإنسان
إنسانا
وهو هو معنى وهذا ما أردنا ذكره في إبطال القول بالقدم وإثبات سبق العدم
وعند ذلك فلا بد من الإشارة إلى شبه أهل التعطيل والإبانه عن معتمداتهم
بطريق التفصيل
الشبهة الاولى
أنهم قالوا لو كان العالم حادثا لم يخل قبل الحدوث من أن يكون ممتنعا أو ممكنا لا جائز أن يكون ممتنعا وإلا لما وجد ولا بغيره وان كان ممكنا فحدوثه بعد ما لم يكن إما لمرجح أو لا لمرجح لا جائز أن يكون لا لمرج والا كان بذاته واجبا ولما كان معدوما في وقت ما وقد فرض معدوما وذلك محال وان كان له مرجح فإما أن يكون قديما او حادثا فان كان قديما فإما أن يكون عند الحدوث كهو قبل الحدوث أو أنه يحدث له أمر لم يكن فإن كان عند الحدوث كهو قبله وجب أن يستمر العدم على ما كان وإن حدث له أمر لم يكن فالكلام في حدوث ذلك الغير كالكلام فيما وقع الكلام فيه أولا وعند هذا فإما ان يتسلسل إلى غير النهاية أو يقف الأمر عند مرجح قديم من كل وجه لم يحدث له أمر لا جائز أن يقال بالتسلسل وان قيل بالثانى فيجب ان يستمر العدم أيضا ولا يقع به الترجيح كما لم يقع به الترجيح اولا وهذا التقسيم بعينه لازم ان كان المرجح برمته حادثا وهذه المحالات كلها انما لزمت من فرض العالم حادثا فلا حدوثالشبهة الثانية
أنه لو كان العالم حادثا لم يخل إما أن يكون بينه وبين البارى تعإلى مدة مفروضة أو لا مدة بينهما فإن لم يكن بينهما مدة لزمت مقارنة وجود العالم لوجود البارى تعالى ومع ذلك
يستحيل ان يكون حادثا والا كان البارى تعالى حادثا لضرورة مقارنته للحادث
وان كان بينهما مدة فإما أن تكون متناهية أو غير متناهية فإن مكانت
متناهية لزم أن يكون وجود البارى تعالى متناهيا أيضا وهو ممتنع وإن كانت
غير متناهية فكما يلزم جواز وقوع مدة لا تتناهى يلزم جواز وقوع عدة لا
تتناهى
الشبهة الثالثة
هو أن الوجود صفة كمال وعدمه نقصان فلو كان العالم قديما لكا البارى تعالى فيما لم يزل جوادا ولو كان حادثا لما كان البارى تعإلى فيما لم يزل جوادا وذلك نقص في حقه ولربما قرروا هذا بتقرير آخر وقالوا لو كان العالم حادثا لما كان وجوده إلا بالإرادة وكل موجد بالإرادة فإنه لا بد وأن يكون الوجود عنده أولى من أن لا وجود وإلا كان فعله للوجود عبثا وكل ما فعله بالفاعل أولى من أن لا فعله فإنه يستفيد بفعله كمالا وبتركه نقصانا والبارى يستحيل أن يستفيد كماله مما هو ناقص مفتقر اليه في وجوده أو أن يكون البارى تعالى قبل حدوث العالم ناقصاالشبهة الرابعة
أنه لو كان العالم موجودا بعد أن لم يكن فكل موجود بعد ما لم يكن لا بد له من زمان ومادة متقدمين عليه أما وجه تقدم الزمان فهو أن ما وجد بعد العدم فله قبل كان معدوما فيه لا محالة وإلا لما كان له أول ثم ذلك القبل إما أن يكون موجودا أو معدوما لا جائز أن يكون معدوما والا لما كان له قبل هو فيه معدوم
فان كان موجودا فليس هو مع ولا بعد إذ القبلية لا تجامع المعية ولا
البعدية بحال وإذا فذلك القبل قد تقضى ومضى وهو المعنى بالزمان ثم ما من
قبل يفرض الا وهو في تجويز العقل مسبوق بقبل آخر إلى ما لا يتناهى وفى
القول بانتهائه إثبات العجز وإبطال التجويز وهو محال
واما وجه
الافتقار إلى سبق المادة فمن وجهين احدهما أنه إذا ثبت سبق الزمان فذلك
مما لا يتم وجوده إلا بموضوع يقومه إذ هو معنى عرضى وأما الوجه الثانى فهو
أن كل حادث بعد ما لم يكون إما أن يكن واجبا أو ممتنعا أو ممكنا لا جائز
ان يكون واجبا والا لما زال موجودا ولا جائز ان يكون ممتنعا وإلا لما وجد
ولا بغيره فبقى أن يكون باعتبار ذاته ممكنا وإذ ذاك فاما أن يكون إمكان
كونه معنى موجودا او معدوما لا جائز ان يكون معدوما والا لما كان الإمكان
على وجوده سابقا إذ لا فرق بين قولنا إن الإمكان معدوم وبين قولنا إنه لا
إمكان فبقى أن يكون موجودا وإذا كان موجودا فهو مما لا سبيل إلى قيامه
بنفسه فتعين افتقاره إلى مادة يقوم بها ويضاف إليها وهكذا في كل ما يفرض
من الحوادث إلى ما لا يتناهى لكن منهم من أثبت لها وجودا مجردا عن الصورة
نظرا إلى أن ما صورة تفرض الا ويمكن القول بفسادها وكون غيرها وما جاز
عروه عن كل واحد واحد من آحاد الصور جاز عروه عن الجميع ومنهم من لم يثبت
لها وجودا دون الصورة بناء على أنه لو كان لها وجود دون الصورة لم يخل إما
أن تكون متحدة او متكثرة لا جائز أن تكون متحدة والا كان ذلك لها لذاتها
ولما تصور عليها نقيض الاتحاد ولا جائز أن تكون متكثرة إذ التكثر لها مع
قطع النظر عن الصور وهما يوجب التغاير والتمييز ممتنع
قالوا وليس
يلزم من جواز عروها في حالة الوجود عن كل واحدة من آحاد الصور جواز عروها
عن جميع الصور لجواز أن يكون الشرط في تحقق وجودها ليس إلا واحدة من الصور
على البدل كيف وأن القول بجواز عروها عن كل ما يقدر من الصور في حالة
الوجود غير مسلم فإن ما وقع به الاشتراك من الصورة الجسمية وهى الأبعاد
التى تشترك بها الأجسام فيما بينها من حيث هى اجسام لا يجوز تبدلها أصلا
وإن جاز القول بتبدل غيرها من الصور واتساع القول في ذلك لائق بالقانون
الحكمى وحقيق بالمنهج الفلسفى
وهذه الشبهة في إثبات المادة هى ما
أوجبت للجمهور من المعتزلة اعتقاد كون المعدوم شيئا وذاتا معينة من غير أن
يصفوه بالوجود لكن منهم من أثبت له خصائص الوجود بأسرها حتى التحيز للجوهر
والقيام بالمحل إن كان عرضا ومنهم من أثبت له خصائص الوجود غير هذين ومنهم
من لم يطلق عليه اسم الشيئية إلا لفظا وعبارة فقط وسنستقصى الكلام في الرد
عليهم إذا انتهينا من الانفصال عن شبه أهل الضلال إن شاء الله تعالى
والجواب
أما الشبهة الاولىفمندفعة من جهة أنه لا مانع من أن يكون حدوث العالم مستندا إلى إرادة قديمة اقتضت حدوثه في الوقت الذى حدث فيه واقتضت استمرار عدمه إلى ذلك الوقت أيضا فعند ذلك لا يكون الحدوث والتجدد لتجدد شئ ولا لعدمه ولا يلزم من وجوده أن يكون مقتضاه موجودا مع وجوده ولا يلزم على هذا إلا ما ذكروه في إبطال القول بالصفات أو استبعاد صلاحية الارادة للتخصيص بناء على أن نسبة جميع الأوقات إليها نسبة واحدة
وقد تكلمنا على ذلك بما فيه مقنع
وكفاية كيف وان ذلك ما يصح استبعاده من الخصم والا لما ساغ له الاعتراف
بوجود حادث ما والا فما ذكره من الشبهة تكون إذ ذاك لازمة له من غير محيص
واما الشبهة الثانية
فإنهم ان أرادوا بالمدة معنى زمانيا وامرا وجوديا حقيقا فالتقسيم بذلك انما يصح على ما هو قابل للتقدم والتأخر والمعية الزمانية وأما على ما ليس بقابل فلا والبارى تعالى ليس بقابل للتقدم والتأخر بالزمان لكون وجوده غير زمانى كما أنه غير قابل للتقدم والتأخر المكانى لكون وجوده غير مكانى فإذا قيل إن تقدمه على العالم بمدة زمانية كان محالا كما أنه محال أن يتقدم على العالم بالمكان وعلى ذلك فلا يلزم بنفى المدة والتقدم الزمانى القول بالمعية بينهما كما لا يلزم القول بنفى المكان والتقدم به المعية أيضا فإذا المعنى بكون البارى تعالى متقدما انه كان ولم يكن معه شئ والمعنى بكون العالم حادثا أو متأخرا أنه كان بعد ما لم يكن وذلك لا يستوجب التقدم بالزمان ولا ولا التأخر بهنعم لا ينكر أن الأوهام قد تنقطع عن الوقوف على مدة لا يرتمى الوهم إلى تقدير مدة قبلها و إلى تقدير مدة بين وجود الواجب بذاته ووجود العالم لكن ذلك كله من تقديرات الاوهام وتخييلاتها فلا يقضى بها على العقليات والأمور اليقينيات بل يجب أن يقضى بكل منهما على تقديراتها ومنها تقدير أن العالم إما خلاء أو ملاء إلى غير النهاية كيف وأنه لما أريد بلفظ المدة الزمان كان التقسيم خطأ إذ الزمان من العالم والكلام أيضا
واقع فيه فإذا قيل إما أن يكون بين البارى
تعالى وبين العالم زمان او ليس فهو محال إذ الزمان الذى وقع الخلاف فيه لا
يكون متقدما على نفسه بحيث يفرض أنه بين نفسه وبين البارى تعالى اللهم إلا
أن يفرض الكلام في بعض الأزمنة وهو غير مقصود بالخلاف إذ ليس هو كل العالم
وانما هو بعضه
واما الشبهة الثالثة
فحاصل لفظ الجود فيها يرجع إلى الدلالة على صفة فعلية وهو كونه موجدا أو فاعلا لا لغرض يعود إليه ولا لنفع يتوجه عليه وعند ذلك فادعاء كونه صفة كمالية ليس هو بأولى من ادعاء كونه ليس بكمال إذا ليس هو من الضروريات ولا من المعانى البديهيات كيف وأنه لو كان من الكمالات لقد كان كمال واجب الوجود متوقفا على النظر إلى ما هو مشروف بالنسبة إليه ومتوقف في وجوده عليه ومحال أن يستفيد الأشرف من مشروفه كماله كما في كونه موجدا بالإرادةثم ولو فرض ذلك فإنما يكون عدمه نقصا أن لو قدر جواز وجود الكائنات أزلا إذ كون الشئ واقعا فرع كونه جائزا و إذ قد بينا أن ذلك ممتنع بما سلف فإذا لا نقص بعدم إيجاد ما هو ممتنع وهذا على نحو قولهم في نفى النقص عنه بمنع ايجاده للحوادث المركبات بناء على امتناع صدورها ووقوعا به من غير واسطة ولا يلزم من عدم جوازه في القدم أن يكون ممتنعا بحيث لا يتصور وجوده ولا في وقت ما وان كان يلزم من ذلك أن يكون في الأزل ممتنعا وذلك أن ما قضى بامتناع وجوده في الأزل هو ما لا يتناهى وما قضى بجواز وجوده ما هو متناه وليس يلزم من امتناع ما لا يتناهى امتناع ما هو متناه
ثم ولو قدر أن وجوده
في الأزل جائز لكن يجب القول بتناهيه كما يجب القول بتناهى أبعاد العالم
وإن كانت بالنظر إلى الجواز العقلى لا تتناهى
وأما ملازمة النقص
للايجاد بالارادة والاختيار فمبنى على رعاية الصلاح والأصلح ووجوب النظر
إلى الأولى وقد بينا وجه إبطاله فيما سلف وبينا أن الفعل وأن لا فعل
بالنظر إلى واجب الوجود سيان وهما بالنسبة اليه متساويان وأنه لا اولوية
ولا ترجيح وان له ان يفعل وأن لا يفعل من غير أن يكون المفعول أو المتروك
نفسه حسنا ولا قبيحا وعلى هذا فهو لا يستفيد بالفعل كمالا ولا بالترك
نقصانا
ثم كيف يصح هذا الإلزام من الخصم مع اعترافه بأن ما في عالم
الكون والفساد من الحركات والامتزاجات وسائر الحادثات مستندة إلى الحركات
الدورية وهى بأسرها تستند إلى ارادة قديمة نفسية ثابتة للأجرام الفلكية
ولا محالة أن الجوهر النفسانى أشرف مما وجب به فإن كان الإيجاد بالارادة
مما يوجب توقف كمال المريد على المراد فكيف قال بذلك في النفس وهى أشرف
مما وجد بها وان كان ذلك مما لا يوجب التوقف فكيف صح إبعاده من الجملة فما
يتحقق جوابا للخصم عن الالزام عن إيجاد الأنفس الفلكية للحركات الدوريه
فهو بعينه جواب لنا ههنا وهذا كله مما قد نبهنا عليه فيما سلف
وأما الشبهة الرابعة
فأما دعوى لزوم سبق الزمان على كل ما حدوثه بعد العدم بناء على قياسه فمبنى على كون القبل أمرا وجوديا ومعنى حقيقيا وليس كذلك بل المعنى بكون الحادث ذا قبل أنه لم يكن فكان وذلك إنما هو أمر سلبى لا معنى وجودى ومهما قيل إنه ذو قبل موجود فلا يعنى به إلا هذا ومهما ورد السلب على القبلية فهو وارد على السلب وذلك لا يجوز إذ سلب السلب ايجاب الإيجاب وهو
محال لما أسلفناه لكن غاية ما يقدر وجود مدة سابقة بناء على تقدير وهمى
وتجويز خيالى وذلك مما لا يقضى به على العقول لما عرف
وبما حققناه ههنا يبطل ما ذكروه من بيان سبق المادة في الوجه الأول ايضا
وأما ما ذكروه في الوجه الثانى
فقد قيل في دفعه إن معنى كون الشئ ممكنا أنه مقدور عليه وذلك مما لا
يستدعى وجود مادة تقوم المقدورية بها وهو غير صواب فإنا لو جهلنا كون الشئ
مقدورا عليه أو ليس مقدورا لم يمكنا التوصل إلى معرفته إلا بكونه ممكنا أو
ليس بممكن فلو كان معنى كونه ممكنا أنه مقدور لقد كان ذلك تعريف الشئ
بنفسه في حالة كونه مجهولا وهو محال
فإذا الصواب أن يقال إن الإمكان
أيضا ليس هو في نفسه حقيقة وجودية ولا ذاتا حقيقية وانما حاصله يرجع إلى
نفى لزوم المحال من فرض وجود الشئ وعدمه وذلك لا يستدعى مادة يضاف اليها
ولا يقوم بها إذ هو في المعنى ليس الا من القضايا السلبية دون الإيجابية
كيف وان ذلك مما لا يصح ادعاؤه من الخصم والا كان واجبا لذاته أو لغيره
فإن كان واجبا لذاته فقد لزم اجتماع واجبين وهو خلاف ما مهدت قاعدته وان
كان وجوبه لغيره لزم أن يكون لذاته ممكنا ثم ولو استدعى الامكان مادة يضاف
اليها سابقة على كون ما قيل له ممكن لكان كل ممكن هكذا وذلك مما يخرم
قاعدة المحققين من الالهيين في النفوس
الإنسانية والجواهر
الصورية فإنها في أنفسها ليست مادية وان كانت ممكنة وجودها بعد ما لم تكن
فإذا الواجب أن يتصور من إمكان كل موجود بعد العدم ما يتصوره الخصم من
إمكان النفوس الانسانية والجواهر الصورية وغير ذلك من الأمور البسيطة
الغير المادية
فان قيل الإمكان وان رجع حاصله إلى سلب المحال عن طرف
الوجود والعدم فهو لا محالة يستدعى ما يصح أن يضاف إليه الوجود والعدم
الذين سلب المحال عن فرضهما وذلك الذى يصح اتصافه بالوجود والعدم هو الذى
يجب أن يكون سابقا وهو المعنى بالمادة وعلى هذا القول فالإمكان السابق على
النفوس الإنسانية والجواهر الصورية إنما هو عائد إلى المواد فيقال إنها
ممكن أن تدبرها النفس الناطقة وممكن أن تحل بها الصورة أما ان يكون عائدا
إلى نفس الصورة والنفس فلا
قلنا ولو استدعى سلب المحال عن فرض
الوجود والعدم مادة يضاف إليها الوجود والعدم لاستدعى الامتناع وهو لزوم
المحال من فرض الوجود مادة يضاف إليها الوجود ولو كان كذلك للزم من فرض
القول بامتناع إلهين ووجود مبدأين تحقق المادة وهو محال ومن رام تفسير
امتناع وجود الشريك أو مبدأ آخر بوجوب انفراد واجب الوجود عن النظير إذ هو
لازم امتناع وجود النظير حتى ترجع الإضافة إلى ذات البارى تعالى فهو مع
تعسفه وإهمال النظر فيما يستحقه الشريك الممتنع لذاته قد لا يسلم عن
المعارضة بنفس الإمكان السابق على الوجود بعد العدم بما يوجب رده إلى ذات
واجب الوجود أيضا وهو أن يقال المعنى بكون الحادث ممكنا قبل وجوده جواز
وجود البارى تعالى مع وجوده إذ هو لازم قولنا ليس بواجب الانفراد ولا
ممتنع ولا محيص عنه وأما رد الإمكان في النفوس
والصور إلى المواد
وكونها ممكنة أن تحل فيها الصور أو تدبرها النفوس فلا يستقيم فإن الصور
والنفوس بإعتبار ذواتها لا تخرج عن أن تستحق الوجوب أو الامتناع أو
الإمكان وقد بان أن الإيجاب والامتناع عليهما ممتنعان فتعين الإمكان
والامكان الثابت للشئ باعتبار ذاته لا يتصور أن يعود إلى غيره ثم وإن صح
ذلك فقد لا يبعد أيضا أن يفسر غيره الامكان في الحادث بجواز إيجاد الموجد
له وعند ذلك فتكون اضافة الإمكان إلى الموجد لا إلى الموجد وبه يندفع ما
ذكروه
فإذا قد ثبت ان الكائنات موجودة بعد ما لم تكن ومسبوقة بالعدم
من غير سبق مادة ولا زمان واندفع ما في ذلك من الخيالات وبطل ما فيه من
الإشكالات
وأما الرد على المعتزلة
في اعتقادهم كون المعدوم شيئافقد سلك بعض المتكلمين في ذلك منهاجا ضعيفا فقال تقرر في أوائل العقول أن النفى والإثبات متقابلان تقابل التناقض وكذلك المنفى والمثبت ولهذا ان من نفى شيئا معينا في حال مخصوص بجهة لم يمكنه القول بإثباته من حيث نفاه قال فإذا كان المنفى ثابتا على أصل من يقول بكون المعدوم شيئا فقد رفع هذه القضية ثم نظم لذلك عبارة فقال كل معدوم منفى وكل منفى ليس بثابت فيترتب عليه أن كل معدوم ليس بثابت
واعلم أن هذا المسلك مما لا يقوى وذلك أن
الخصم وان سلم أن التقابل واقع بين النفى والإثبات والوجود والعدم فهو لا
يسلم ترادف النفى والعدم ولا الوجود والثبوت حتى يلزم من تقابل الإثبات
والنفى أو من تقابل الوجود والعدم تقابل الإثبات والعدم بل مدلول لفظ
الثبوت عنده أعم من مدلول لفظ الوجود فكل موجود ثابت وليس كل ثابت موجود
وعند ذلك فلا يلزم من العدم النفى ولا التقابل من القضاء عليه بالإثبات
لكنه قد وجه بعد ذلك خيالا رام به دفع هذا الاشكال فقال إذا كان الاثبات
أعم من الوجود وهو عام له وللعدم فهلا قيل مثله في مقابله وهو النفى فيكون
النفى أعم من العدم حتى يكون بصفة عمومه حالا ووجها ثابتا للمنفى كما كانت
صفة خصوص العدم حالا ووجها ثابتا للمعدوم وذلك يفضى إلى تحقق الإثبات
للنفى في الحال وان قلتم بأنه لا فرق بين المنفى والمعدوم فيلزم من القضاء
على كون المعدوم شيئا ومعنى ثابتا رفع التقابل بين النفى والإثبات وهو
محال
ولم يعلم أن ادعاء عموم النفى بالنسبة إلى المعدوم بعد تسليم
عموم الثبوت بالنسبة إلى الموجود والمعدوم مما يشعر بعدم اطلاعه على معنى
التقابل وأحكامه وذلك أن من أحكام التقابل أن يكون كل واحد من المتقابلين
عند صدقه أخص من مقابل ما هو أخص من مقابله ولا يجوز أن يكون مساويا له
ولا اعم منه صدقا وان كان اعم منه كذبا و لا يجوز ايضا ان يكون مساويا له
و لا أخص منه من جهة الكذب وذلك لأنه مهما صدق أحد المتقابلين كذب الآخر
بالضرورة فإذا كان الكاذب أعم من غيره لزم كذب ذلك الغير لأنه مهما كذب
الأعم كذب الأخص ضرورة من غير عكس ومهما كذب ذلك الأخص فمقابله صادق لا
محالة وعند ذلك فلو كان هذا المقابل المفروض صدقه ثانيا مساويا للمفروض
صدقه أولا في الصدق والكذب للزم منه مساواة نقيضه في الصدق والكذب لما
فرض أعم منه أولا لضرورة كونهما نقيضين لمتلازمين في الصدق وأنه
مهما صدق
أحد المتلازمين المتعاكسين صدق الآخر ويلزم من فرض صدقهما كذب نقيضهما
أيضا بجهة التلازم وكان قد فرض أحدهما أعم من الآخر ومحال ان يكون الأخص
مساويا لما هو أعم منه وكذا لو فرض أخص منه
وإذا عرف ذلك في حالة
الصدق أمكن نقله إلى حالة الكذب بعينه أيضا ومن اعتاص عليه فهم هذا الفصل
ههنا فعليه بمراجعة كتبنا المختصة بهذه الصناعة فمهما وقع التسليم بكون
الثبوت اعم من الوجود المقابل للعدم فمهما صدق الثبوت لزم أن يكون مقابله
وهو النفى أخص من العدم الذى هو مقابل الوجود لضرورة كونه أخص من الثبوت
حتى يكون كل منفى معدوما ولا يلزم أن يكون كل معدوم منفيا وإلا للزم منه
مساواة الأعم للأخص كما بيناه وهو محال ثم إنه وإن صدق كون النفى عاما او
خاصا فليس يلزم عند الخصم أن يكون كل ما خص أو عم حالا ثابتة حتى يلزم
الثبوت للمنفى بل الاشتراك قد يقع عنده في السلوب وليست السلوب عنده
أحوالا بل هى أعدام محضة والحال لا يوصف عنده بالعدم كما لا يوصف بالوجود
وكذلك قد يكون الافتراق بالسلوب كما يكون بالأحوال وذلك بأن يكون ما ثبت
لأحد الشيئين مسلوبا عن الآخر فيكون التمييز بينهما بثبوت الحال في أحدهما
ونفيها عن الآخر وذلك كما في التمييز بين الموجود في حال وجوده وبينه في
حال عدمه فليس العدم عنده حالا ثابتة للمعدوم حتى يقاس عليها الثبوت أيضا
ولقد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقا آخر فقال نفرض الكلام في السواد
والبياض مثلا فإنه عند الخصم ذات ثابتة وحقيقة معنية فنقول ذات السواد في
حال العدم لا تخلو إما أن تكون لذاتها متحدة أو متكثرة فإن كانت متحدة لم
تقبل التكثر
فإن ما كان مستحقا للوحدة باعتبار ذاته استحال عليه التكثر في
نفسه وان كانت متكثرة فهو أيضا باطل من ثلاثة أوجه
الوجه الأول هو أن التكثر اما باعتبار صفات ذاتية أو باعتبار صفات عرضيه
لا جائز أن يكون التكثر باعتبار صفات ذاتية إذ الكلام واقع في نوع السواد
من حيث هو سواد ولا اختلاف فيه من حيث هو سواد وإن كان الاختلاف باعتبار
امور عرضية والأمور العرضية يخصصها قيامها بكل واحد من الآحاد النوع وهو
فرع تحقق ذلك الواحد بما خصصته من الأمور الذاتية وذلك يفضى إلى ان تكون
العرضيات سبب تكثر ما لا يتصور قيامها به إلا بعد تكثر وهو دور
الوجه الثانى هو ان المميزات المعلومة بأسرها ممتنعة في حال العدم وهى
الزمان والمكان والجهة وغير ذلك فالتكثر يكون غير معقول
الوجه الثالث هو أنها لو كانت متكثرة لم تخل إما أن تكون متناهية أو غير
متناهية فإن كانت متناهية فليس القول بثبوت بعض الجائزات بأولى من البعض
إذ الجائزات غير متناهية وان كانت غير متناهية فاذا أخذت مع ما خرج منها
إلى الأعيان أمكن فيها فرض الزيادة والنقصان بأمر متناه ووقوع ذلك بين ما
ليسا متناهين محال
وذلك أيضا غير مرضى وهو أن ما ذكره نفسه لازم له
في الذوات الموجودة فإنه يصح أن يقال اما أن تكون مستحقة لذواتها الكثرة
أو التوحد لا جائز أن تكون مستحقة للوحدة ولا لما تكثرت وان كانت متكثرة
فالتكثر اما بأمور ذاتية أو بأمور عرضية وهلم جرا إلى أخر الالزام ولا
محيص عنه فما هو جواب له ههنا هو جواب الخصم أيضا
وما ذكره في الوجه الثانى من أن الأسباب الموجبة للكثرة بأسرها ممتنعة في
حالة
العدم فإنه إن أريد به انتقاء الوجود فصحيح وان أريد به انتفاء
الإثبات
فذلك مما لا يسلمه الخصم بل ما وقع موجبا للتكثر في حالة الوجود بوجوده
فهو بعينه موجب للتكثر في حالة العدم بثبوته كيف وأنه مع ما فيه من
الركاكة مناقض للوجه الأول من جهة أنه يتضمن القول بجواز التمييز بالأمور
العرضية والوجه الأول يمنعه
وما ذكره في الوجه الثالث من امتناع
ثبوت ذوات لا نهاية لها بناء على فرض وقوع الزيادة والنقصان بأمر متناه
فقد سبق وجه إفساده فيما مضى
فإذا الرأى الحق والسبيل الصدق أن يقال
لو كانت الذوات ثابتة في العدم فعند وجودها إما أن يتجدد لها أمر لم يكن
لها في حال عدمها أو ليس فإن قيل بالأول فهو أيضا إما جوهرا وإما عرضا
وإما حالا زائدا عليهما لا جائز أن يكون جوهرا ولا عرضا إذ قد فرضت
ذواتهما ثابتة بديا إذ لا فرق في ذلك بين جوهر وجوهر ولا بين عرض وعرض وان
كان حالا زائدة فهو مبنى على القول بالأحوال وقد سبق إبطالها
وإن
قيل بالثانى لم يكن فرق بين الوجود والعدم وهو محال والقول إذا بالحدوث
والوجود محال وهذا المحال إنما لزم من فرض الذوات ثابتة في العدم ومتحققة
في القدم فلا ثبوت لها والتحقق بالحدوث والثبوت إنما هو لنفس الذوات
الجوهرية والعرضية لا غير
وأيضا فإنا نفرض الكلام في السواد والبياض
فنقول لو كانت ذواتها ثابتة في العدم فإما أن تكون مفتقرة إلى محال تقوم
به أو غير مفتقرة لا جائز أن تكون غير مفتقرة وإلا فعند وجودها إما أن
تفتقر أو لا تفتقر القول بعدم الافتقار محال والا لما وقع الفرق بين
الجواهر والأعراض وان افتقرت فإما ان تفتقر إلى المحل بإعتبار ذواتها
أو باعتبار أمر وجودها ولا جائز أن تكون مفتقرة من حيث وجودها إذ
الوجود
من حيث هو وجود عند الخصم قضية واحدة شاملة للجوهر والعرض فلو افتقر العرض
إلى المحل من حيث وجوده لافتقر الجوهر أيضا وهو ممتنع فبقى أن يكون
الأفتقار إلى المحل من حيث ذواتها وإذ ذاك فلا فرق بين أن تكون موجودة أو
معدومة فان ما هو المفتقر في حالة الوجود هو بعينه الثابت في حالة العدم
وإذا كانت مفتقرة إلى محل تقوم به فإذا فرضنا سوادا وبياضا متعاقبين على
محل واحد في طرف الوجود فإما أن يكونا قبل وجودهما قائمين بذلك المحل أو
أحدهما قائم به والآخر قائم بغيره لا جائز أن يكون أحدهما قائما به والآخر
قائما بغيره وإلا فعند وجوده فيه يلزم عليه الانتقال والانتقال على
الأعراض محال فبقى أن يكونا ثابتين فيه بصفة الاجتماع في حالة العدم ولو
كان كذلك لما استحال القول باجتماعهما فيه في حالة الوجود إذ الاستحالة
إما ان تكون باعتبار ذاتيهما أو باعتبار وجوديهما لا جائز أن تكون
الاستحالة بينهما والتنافر باعتبار وجوديهما إذ الوجود فيهما بمعنى واحد
لا اختلاف فيه فتعين أن تكون الاستحالة باعتبار ذاتيهما فإذا لم يكن
بينهما تنافر في العدم لم يكن بينهما تنافر في الوجود أيضا لكن الاستحالة
والتنافر ثابت في الوجود فيكون ثابتا في العدم فيلزم من كونهه ثابتا في
حالة العدم امتناع قيامهما بمحل واحد لضرورة التنافر أو بمحلين لضرورة
استحالة الانتقال عند فرض التعاقب ويلزم من امتناع قيامهما بالمحل امتناع
ثبوتهما في نفسيهما لضرورة أن لا قوام لها ولا ثبوت إلا بالمعدوم وهو
المطلوب
فإن قيل تعلق العلم والاخبار عنه بكونه مقدورا أو ممكنا
وصحة التصرف فيه بالعموم والخصوص حتى انقسم إلى الجائز والمستحيل يستدعى
متعلقا لهذه العلاقات وصحة هذه التصرفات وذلك لا يتم الا أن يكون المتعلق
شيئا ثابتا وذاتا متعينة وإلا فإضافة العلم والإمكان والقدرة والعموم
والخصوص وغير ذلك من الأحكام لا إلى شئ وهو محال كيف وأنه لو لم تكن
الذوات ثابتة في العدم متميزة بذواتها في القدم لما تصور من الفاعل
إيجادها ولا القصد إلى إحداثها من جهة أن التخصيص بالوجود والقصد له فرع
تميزه
عند الفاعل ولا كان الإيجاد لموجود لا تعرف عينه وهويته في نفسه
ولعله يقع جوهرا ولعله يقع عرضا
وكل ذلك خبط في عشواء والجواب هو أنا نقول تعلق العلم بالمعدوم ليس يرجع
إلا إلى حكم النفس بانتفاء ما وقع متصورا للنفس من الذوات وسواء كان وجود
ذلك المتصور من الذوات حقيقيا أو تقديريا وذلك لا يستدعى ثبوت ذاته لتعلق
العلم بانتفائه والا كان المعلوم نفيه ثابتا وهو محال بل تعلق العلم
بالعدم وان كانت ذاته غير ثابتة على نحو تعلقه بما هو متعلق بالقدرة
كالوجود الزائد على الذات وبتوابعه كالجهات والحركات وغير ذلك من الصفات
عند الخصم فإن ذات الوجود وتوابعه غير ثابتة أزلا لضرورة القول بحدثه
وبكونه مقدورا والعلم متعلق بانتفائه قبل الحدوث لا محالة وما لزم من تعلق
العلم بانتفائه القول بثبوت ذاته أصلا
وعلى ما حققناه يتضح الجواب
عن كونه مقدورا وممكنا أيضا وما وقع به الاتفاق والافتراق بين المعدومات
أيضا فإن ما وقع به الاشتراك بين الجائز والمستحيل انما هو نفس لنفى
والعدم وقد بان أن ذلك لا يستدعى ثبوت ذات يضاف اليها وما وقع به الافتراق
أيضا ابين الاستحالة والجواز غير مفتقر لذلك أيضا أما الاستحالة فظاهر لا
محالة وكذا الجواز لما أسلفناه في الرد على شبهة معلم المشائين أيضا ثم
كيف يمكن دعوى مع اعترافه بجواز تعلق القدرة مع الوجود لضرورة انتفاء
الوجوب والامتناع عنه ومع ذلك فلا ثبوت لذاته عند الحكم بجوازه قبل حدوثه
وأما ما ذكروه من فصل التمييز بين الجوهر والعرض فغايته استبعاد
العلم بما
قصد إلى إيجاده وتصور حقيقته على وجه يتميز بخصوص وصفه عن غيره وذلك لا
يلزم منه تحقق الذات في نفسها أو ثبوتها قبل الحدوث لما سبق ثم ولو استدعى
ذلك ثبوتها قبل الحدوث لجاز أن ما كان منها مشارا إلى جهته بعد الحدوث أن
يكون مشارا إلى جهته قبل الحدوث أيضا وذلك أن ما له الجهة وهو الواقع في
امتداد الإشارة اما أن يكون نفس الوجود الذى هو متعلق القدرة فهو محال
فإنه ذات معقولة وليس بمحسوس بحيث يكون في الجهة ويقع في امتداد الإشارة
وان كان ذلك ثابتا للذات والذات ثابتة قبل الحدوث فوجب أن يكون او جاز أن
يكون في الجهة وهو محال
ومثار الجهل ومنشأ الخيال ههنا لأهل الضلال
في اعتقاد كون المعدوم شيئا إنما هو من تطفلهم سلوك مسلك الهيولانين
ونسجهم على منوال الفلاسفة الالهيين وظنهم أن ذلك من اليقينيات وانه لا
منافرة بينه وبين القول بحدث الكائنات ولهذا لما تخيل بعضهم ما فيه من
الجهالة وشحذ راية الضلال قال إنما نطلق عليه اسم الشئ والذات من جهة
الألفاظ والعبارات وربما تمسك في ذلك بالسمع وظواهر واردة في الشرع مثل
قوله تعالى ولا تقولن لشئ إنى فاعل ذلك غدا وكذلك قوله إن زلزلة الساعة شئ
عظيم فإنه قد سمى الساعة والفعل قبل كونهما شيئا وهذا وإن كان نزاعا في
اللفظ دون المعنى وأنه أقل طغاوة من الأول لكنه مما لا عليه معول ومعنى
قوله ولا تقولن لشئ إنى فاعل أى فاعل غدا شيئ إلا أن يشاء الله وكذا
تسميته زلزلة الساعة شيئا إنما هو في وقت كونهما وهذا على رأى من لا يعترف
منهم بكون المعدوم متحركا أولى وأحرى من جهة
أن الزلزلة حركة على
ما لا يخفى ثم إن هذه الظواهر قد لا تسلم عن المعارضة بمثلها وذلك مثل
قوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
وهذا آخر ما أردنا ذكره من القانون الخامس
والله ولى التوفيق
القانون السادس
فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجسادرأى الفلاسفة الإلهيين
والذى ذهبت إليه الفلاسفة أن الأنفس الإنسانية باقية بعد الأبدان ولا يلزم فواتها من فواتها ولا لسبب خارجأما أنه لا يلزم فواتها من فواتها فلأن كل شيئين لزم فوات أحدهما من فوات الآخر لا بد وأن يكون له به نوع تعلق والتعلق إما بالتقدم أو بالتأخر او المعية والتكافى فلو فاتت النفس بفوات البدن للزم أن يكون لها أحد هذه الأقسام من التعلق
فإن تعلقت به تعلق المتقدم عليه فلا محالة أنه إن كان ذلك النوع من التقدم بالزمان أو المكان او الشرف أو الطبع أنه لا يلزم من فوات المتأخر عنه في تلك الرتبة فواته وان كان التقدم بالذات وهو أن يلزم من وجوده وجود ما هو متأخر عنه فلا محالة أنه يلزم عند فرض عدم المتأخر عدم المتقدم لكن لا لأنه لزم من عدم المتأخر عدم المتقدم بل لأنه لا يكون إلا بعارض في جوهره وعدم المتأخر يكون بسبب عدمه إذ هو المرجح له
وان كان التعلق بالمكافأة في الوجود فهما متطابقان فإن كانا
حقيقيين فلا
محالة أن ما وقع بينهما من التكافى انما هو بسبب عارض لهما كما في الأب
والابن ولا يخفى أن فساد أحدهما في ذاته لا يوجب فساد الآخر في ذاته وان
لزم من ذلك فساد العارض الذى أوجب الإضافة بينهما وان كان تعلقها تعلق
المتأخر في الوجود فلا محالة أنه لا يلزم من فواته فواتها الا أن يفرض
تقدمه بالذات كما بيناه ولو كان متقدما عليها بالذات لكان علة لها والعلل
أربعة إما فاعلية أو مادية أو صورية أو غائية لا جائز أن يكون فاعلا لها
فإنه إما أن يكون فاعلا بنفسه أو بقواه لا جائز أن يكون فاعلا بنفسه وإلا
كان كل جسم كذا ولا جائز أن يكون فاعلا بقواه والا كان الموجود في الموضوع
مقوما لما وجوده لا فى موضوع وهذا محال ولا جائز أن يكون لها كالمادة فإن
النفس ليست منطبعة في الجسم كما يلى ولا جائز أن يكون كالصورة أو الغاية
إذ الأولى أن يكون بالعكس وإذ ذاك فلا يلزم فوات النفس من فوات البدن
ولا يتصور فواتها بسبب خارج ايضا وإلا كانت قبل الفساد لها قوة قابلة
للفساد وقد كان لها إذ ذاك قوة قابلة للبقاء بالفعل فهاتان القوتان
مختلفتان الإضافة لا محالة فيستحيل اجتماعهما في شئ واحد لا تركيب فيه
والنفس بسيطة لا تركيب فيها ولا انقسام بوجه ما والا فإدراكها لما لا
انقسام له في ذاته من الامور الكلية والمعانى العقلية إما بجزء واحد أو
بكل جزء لا جائز أن يكون بجزء واحد والا كان باقى النفس معطلا
ولا جائز أن يكون بكل واحد من الأجزاء والا فما أدرك بكل واحد
إما نفس ما
وقع مدركا للآخر أو غيره فأن كان هو أفضى إلى أن يكون الشئ الواحد معلوما
كرات متعددة في حال واحدة وهو محال وان كان ما أدرك بكل واحد غير ما أدرك
بالآخر لزم أن يكون المدرك في نفسه متحيزا وقد فرض غير متحيز فإذا ليست
النفس جرما ولا قائما في جرم إذ الجرم متجرئ إلى غير النهاية وإلا كان ما
فرض منه غير منحاز إلى جهة ليس هو ما هو منه منحاز إلى جهة اخرى ولكان ما
فرض منه على ملتقى مثليه محاذيا لهما أو لأحدهما لضرورة ألا يكون محاذيا
لبعض كل واحد منهما وذلك كله محال فإذا اجتماع القوى المختلفة الإضافة
فيها ممتنع
ولربما قالوا أن ما قبل البقاء والفساد فلا بد له عند
تحقق كل واحد من الأمرين من وجود القوة القابلة له وعند تحقق العدم لا بد
من تحقق الحمل للقوة القابلة والا فلا عدم كما ان ما كان قابلا للوجود فلا
بد فيه من أن يكون الحامل للقوة القابلة للوجود متحققا وإلا فلا وجود وان
يكون ما طرأ غير ما فقد وما فقد هو غير ما طرأ وذلك في غير المادة محال
فلو قبلت النفس الفساد للزم أن تكون مادية ومركبة وهو ممتنع لما مضى فإذا
النفس لا فوات فيها بعد فوات البدن
ثم زعموا أن سعادة كل شئ إنما هو بحصول ماله من الكمالات المختلفة له وذلك كما في البصر بالنسبة إلى العين والسمع بالنسبة إلى الأذن ونحوه وكذلك شقاوته إنما هو بعدم ظفره بما له من تلك الكمالات فسعادة النفس الناطقة انما هى بحصول ما لها من الكمال الممكن لها وهو مصيرها عالما عقليا متصلة بالجواهر الروحانية ومطلعة على المعقولات محيطة بالمعلومات وكذلك أيضا شقاوتها إنما هى بعدم ظفرها بهذا الكمال الممكن لها فحالها بعد المفارقة للبدن ان كانت قد استعدت لقبول كمالها واستكملت بإشراف العقل الفاعلى عليها فلها حالتان الحال الأول أن تكون في حال المفارقة قد عقلت شيئا من كمالها ومطلوبها بالبحث عنه والاهتمام به فإن حصول ذلك لها ليس بطبعها والا كان ذلك موجودا معها بالفعل حيث وجدت فحصول ذلك لها مع اشتغالها به عن الرذائل و العوائق البدنية على الدوام هو نعيمها بعد المفارقة وفوزها باللذة الدائمة في جوار رب العالمين ولا محالة أن على قدر تحصيلها تكون زيادة سعادتها في الأخرى
قالوا وليس ما يحصل لها من اللذة يحصل مثل المطلوب مما شاكل
اللذة الحاصلة
من غيره من المطاعم والمشارب وغير ذلك من الكمالات الحاصلة للحيوانات إذ
الالتذاذ وزيادته إنما هو على حسب جمال الشئ المدرك وقوة الإدراك له
ودوامه ولا يخفى أن شرف كمال النفس بالنسبة إلى غيره من الكمالات كنسبة
شرف جوهر النفس بالنسبة إلى غيره من الجواهر وكذا أيضا إدراك النفس لما
تدركه ليس مثل إدراك غيرها من القوى من حيث إن إدراكها للأمور الكليات
والحقائق والماهيات ولا كذلك غيرها وكذا أيضا كمالها أدوم من كمال غيرها
فالتذاذها به ليس من التذاذ غيرها بكماله وليس التذاذها به أيضا بعد
المفارقة على نحو التذاذها به قبل المفارقة إذ النفس قبل المفارقة مشغولة
بالعوائق البدنية والموانع الدنيوية وقد زالت هذه الموانع بعد المفارقة
وغير خاف أن الالتذاذ بالشئ عند زوال المانع يكون أشد منه عند وجوده
واللذة الحاصلة منه أعظم وأتم وليس نسبة هذه اللذة إلى تلك اللذة إلا على
نحو نسبة لذة الأكل إلى لذى شم رائحة المأكول أو أشد
وهى وإن كنا لا
نعرفها على ما هى عليه ولا نتشوقها غاية الشوق لكوننا مشغولين بالعوائق
والعلائق فإنا لا محالة نقطع بوجودها كما يقطع العنين بلذة الجماع أو
الأكمه بتخيل بعض الصور وإن كان لا يتشوقها ولا يعرفها على نحو معرفة غيره
بها وتشوقه إليها ممن ليس بعنين ولا أكمه فهذه هى اللذة والنعيم الدائم
الذى لا يشبهه شئ من أنواع الملاذ
وإن كانت النفس مع ما حصل لها
مشتغلة عنه بالفجور والانغماس في الرذائل فهذه النفس تسمى المؤمنة الفاجرة
فما استقر فيها من تلك الهيئات والشهوات والقبيحات يجذبها إلى أسفل وما
حصل لها في جوها من الكمالات يجذبها إلى الملإ الأعلى فقد يحدث ذلك
التجاذب والتضاد ألما عظيما وعذابا أليما وعلى حسب رسوخ تلك الهيئات
القبيحة في النفس يكون دوام هذه الآلام لكنها مما لا يتسرمد لكون الموجب
لها عارضا والعارض قد يزول على تطاول الزمان
الحال الثانى
ألا
تكون قد حصلت شيئا من كمالها ولا اشتغلت بشئ من مطلوبها فهى إن كانت مع
ذلك زكية طاهرة مشتغلة بالرياضات وأنواع النسك والعبادات عن الرذائل
والشهوات فلا يبعد أن تتصل بعد المفارقة للأبدان ببعض الأجرام الفلكية
فتتخيل به على نحو تخيل يقظاننا ما كان قد استغرقها من صور الملاذ من
المطعومات والمشروبات وتكون لذة ذلك بالنسبة إليها تزيد على ما كانت تجده
من لذته في دار الدنيا على نحو ما يجد النائم في منامه في زيادة لذة
المنكوح أو المأكول بالنسبة إلى ما يجده من اللذة في حالة كونه يقظان
منتبها
وإن كانت في ذلك منغمسة في الشهوات البهيمية منهمكة على
الرذائل الدنياوية بحيث اشتدت إليه قوتها الرغبية فبعد المفارقة تجد من
العذاب الأليم على حسب ما تجده النفس
الزكية من لذة النعيم
المقيم وذلك بسبب تنبهها لفوات مطلبها وانجذابها إلى العالم السفلى بما
استقر فيها من تلك الرذائل واستحكم فيها من صور تلك القبائح
وإن
كانت مع ذلك كله مستقرة على المجاحدة منكبة على اعتقادات فاسدة فإنها تجد
الألم ما يزيد ويربى على حالها أولا لاستحكام صورة نقيض الحق في جوهرها
وتكون حالها بالنسبة إلى هذا الألم كحالة من يرجح لفساد مزاجه الأشياء
الكريهة على المستلذة فإنه إذا صلح مزاجه وزال عنه المرض وهو مستمر على
أكل ذلك الشئ المستكره فإنه يجد من نفسه تألما لا يجده من لم تكن حاله
كحاله
قالوا ويشبه ان تتصل هذه الأنفس الفاجرة بعد المفارقة ببعض
الأجرام الفلكية فتتصور به نقيض ما تتصور الأنفس الزكية الجاهلة فيحصل لها
من الالم إذ ذاك حسب ما يحصل لتلك النفوس الجاهلة الزكية من الالتذاذ
والنعيم
هذا كله إن كانت النفس الناطقة قد استعدت لقبول كمالها قبل
المفارقة وتنبهت لمعشوقها وإن لم تكن قد استعدت له فهى لا تجد بعد
المفارقة شيئا مما ذكرناه وذلك كما في الأنفس الساذجة كأنفس الصبيان
والمجانين ونحوهما بل حالها بعد المفارقة وإن كانت حالة حصول الالتذاذ
كحالها قبل المفارقة فهى كمن خلق أكمه أو عنينا فإنه
عند بلوغ وقت الالتذاذ لا يجد لفواته ألما ولا يحس من نفسه لذلك
أثرا هذا حكم معاد الأنفس
وأما الأبدان فإنهم قضوا باستحالة إعادتها وزعموا أن ذلك مما يفضى إلى
القول بوجود أبعاد وامتدادات لا تتناهى لضرورة وجود أجسام لا تتناهى وبنوا
على ذلك فاسد أصلهم في القول بالقدم واستحالة سبق ما تجدد من الأبدان
بالعدم وما ورد به السمع من حشرها وأحكام معادها فإنما كان ذلك لأجل
الترغيب والترهيب بم يفهمونه ويعقلونه لأجل صلاح نظامهم وإلا فلا بد من
تأويل على نحو تأويل أخبار الصفات وما ورد فيها من الآيات جمعا بين قضيات
العقول وما ورد به الشرع المنقول
وأما التناسخية
فإنهم وافقوا الفلاسفة في القول بوجوب بقاء الأنفس بعد مفارقة الأبدان لكنهم زعموا أنه لا قوام لها بعد مفارقة بدنها إلا ببدن آخر كما أنه لا وجود لها قبل البدن فالأبدان تتناسخها أبدا سرمدا وعلى حسب عملها يكون ما تنتقل إليه فإنها إن عملت على مقتضى جوهر النفس الناطقة انتقلت إلى بدن نبى أو ولى وإن عملت على مقتضى جوهر النفس الحيوانية انتقلت إلى بدن حيوان آخر من فرس أو حمار أو غيره وهكذا لا تزال في الانتقال والارتفاع والانخفاض وليس ثم حشر ولا معاد ولا جنة ولا نار ولا غير ذلك مما ورد به الرسول ومذهب أهل الحق من الإسلاميين القول بالحشر والنشر وعذاب
القبر ومساءلة مكنر ونكير ونصب الصراط والميزان والجنة والنار والثواب
والعقاب وقبل الخوض في ذلك بالتفصيل يجب تقديم النظر في إبطال مذاهب أهل
التعطيل
أما الفلاسفة الالهيون
فالخواص منهم متفقون على امتناع وجود الانفس قبل الأبدان وأنه لا وجود لها إلا عند وجود الأبدان وسلكوا في ذلك طريقا شددوا به النكير على من قال منهم بقدمها قالوا لو فرض قدم النفس على البدن لم يخل إما أن تكون متكثرة أو متحدة لا جائز أن تكون متكثرة إذ التكثر من غير مميز حال وكل ما يفرض من الفواصل والمميزات قبل وجود الأبدان محال ولا جائز أن تكون متحدة وإلا فعند بدء الأبدان ووجودها بالفعل إما أن تبقى متحدة أو تتكثر لا جائز أن يقال بأنها تبقى متحدة وإلا فنسبتها إلى بدن واحد أو كل الابدان لا جائز أن تكون نسبتها إلى بدن واحد دون غيره من الأبدان إذ لا أولوية ثم وإن ذلك يفضى إلى تعطيل باقى الأبدان عن الأنفس وهو محال فإن قيل نسبتها إلى كل
الأبدان مع كونها متحدة فهو أيضا ممتنع وإلا فيلزم أنها إذا علمت شيئا أو
جهلته أن يشترك الناس بأسرهم فيه لاشتراكهم في نفس واحدة ولا جائز أن يقال
بتكثرها عند وجود الأبدان لأن تكثر ما لا يقبل التكثر والانقسام أيضا محال
وهذه المحالات كلها إنما هى لازمة من فرض وجود الأنفس قبل وجود الأبدان
فلا وجود لها قبلها
فعلى هذا ما ذكروه في امتناع لزوم فوات النفس من
فوات البدن لو قلب عليهم في طرف لزوم وجودها من وجوده لم يجدوا إلى
الانفصال عنه سبيلا وذلك أن يقال كل شيئين لزم وجود أحدهما من وجود الآخر
لا بد وأن يكون بينهما علاقة وارتباط وذلك التعلق إما على سبيل لزوم تقدم
أحدهما على الآخر أو على سبيل التكافؤ في الوجود فلو لزم وجود النفس من
وجود البدن لكان بينهما تعلق على النحو المذكور وما ذكروه من المحالات
اللازمة من فرض فوات النفس بفوات البدن تكون إذ ذاك بعينها لازمة ههنا فما
هو الجواب عنها في لزوم الوجود هو جوابنا في لزوم الفوات من الفوات
فإذا لا استبعاد في لزوم فوات النفس من فوات البدن ولا مانع من أن يكون
وجود البدن في كل حين شرطا لوحودها كما كان وجوده ابتداء شرطا في ابتداء
وجودها وما حصل لها من المميزات والمخصصات عند وجود الأبدان حتى قيل
بتكثرها ووجودها بناء عليها فلا محالة أنها بأسرها تفوت بفوات ما أوجبها
ولو جاز القول بوجودها وتكثرها بعد
الأبدان لما كان لها من النسب
إليها لجاز القول بتكثرها ووجودها قبل وجود الأبدان لما ستنسب إليها ثم
ولو قدر أن فواتها غير لازم من فوات البدن لكن لا مانع من أن يكون فواتها
مستندا إلى إرادة قديمة اقتضت عدمها عند فوات البدن كما اقتضت وجودها عند
وجوده إذ قد بينا أن كل كائن فاسد فإسناده إنما هو إلى إرادة قديمة لا إلى
طبع وعله
وما ذكر من امتناع قيام قوى القبول للكون والفساد بالنفس
فإنهم إن فسروا القوة القابلة للكون بإمكان الكون والقوة القابلة للفساد
بإمكان الفساد وفلا محالة ان معنى كون الشئ ممكنا أن يكون وممكنا أن يفسد
ليس إلا أنه لا يلزم عنه فى ذلك كله محال فحاصل الإمكان يعود إلى سلب محض
وذلك وان تعدد فلا يمتنع اجتماع كثير منه فى شئ واحد لا تعدد فيه إذ هو
غير موجب للكثرة
وإن فسرت القوة القابلة بأمر موجب للتكثر فمع كونه
غير مسلم هو لازم لهم في الصور الجوهرية من التوالى فإنها قابلة للكون
والفساد وذلك لا يكون بقابل فلو كان القابل للكون والفساد مما يوجب التكثر
أوجب في الصور الجوهرية وهو ممتنع بل هو أيضا لازم في النفس في جانب
قبولها للاتصال بالبدن والانفصال عنه فكل ما يفرض من الجواب فهو بعينه
جواب لنا في محل النزاع كيف وأن ما ذكروه فمبنى على امتناع قبول النفس
للتجزى وهو وإن كان ممكنا ومقدورا لله تعالى فهو مما لا يدل على وقوعه عقل
ولا أشار إليه نقل
وما اشاروا إليه فى ذلك فهو يناقض مذهبهم في
إدراك القوة الوهمية لما تدركه من المعنى الذى يوجب نفره الشاة من الذئب
فإنه لا محالة غير متجزئ وإن كانت لا تدركه إلا إدراكا جزئيا أى بحسب شكل
شكل وصورة صورة ومع ذلك فهى نفسها لا تدرك الا بآلة جرمانية ولهذا قضى
بفواتها عند فوات البدن فما هو الاعتذار لهم ايضا في إدراك القوة الوهمية
بالآلة الجرمانية لما ليس بمتجزئ هو اعتذارنا في إدراك ما ندركه مما ليس
بمتجزئ
ثم كيف ينكر كون النفس مادية ممكنة مع ما عرف من أصلهم أن
جهة الامكان لا تقوم إلا بمادة والنفس ممكنة الوجود ولا محالة فإذا قد ظهر
امتناع دلالة العقل على بقاء النفس بعد فوات البدن
ثم ولو قدر
بقاؤها بعد فوات البدن عقلا كما ثبت ذلك سمعا بقوله ولا تحسبن الذين قتلوا
الأية وقوله عليه السلام إن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر معلقة تحت
العرش وقد بان لها من النعيم والألم بعد المفارقة نحو ما تخيلوه فليس
بمستبعد عقلا ولا شرعا إذ ليس فيه تناقض عقلى ولا محذور شرعى والأمر فيه
قريب والخطب فيه يسير وإنما الداهية الدهياء والمصيبة الطخياء استنهاك
جانب الشرع المنقول والرد لما جاء به الرسول من حشر الأجساد وما أعد لها
من النعيم والألم في المعاد
وإنكار الجمع في الشقاء والنعيم بين
الجسمية والروحانية من غير دليل عقلى ولا نقل سمعى استند اليه من أنكر بعث
الأجساد وأحكامها في المعاد فمبنى على فاسد اصلهم في القول بالقدم وقد
أبطلناه بما فيه كفاية
وأما التناسخية
فقد سلكت الفلاسفة في الرد عليهم مسلكا وهو انهم قالوا كل بدن فإنه مستحق لذاته نفسا تدبره وتنظر فى أحواله وتوجد عند وجوده بشوق جبلى وميل طبيعى على نحو ميل الحديد إلى المغناطيس فلو صح التناسخ وانتقال نفس من بدن إلى بدن لأدى إلى اجتماع نفسين في بدن واحد وهى النفس التى يستحقها لذاته والنفس التى انتقلت إليه من غيره وذلك محال فإن الواحد منا لا يشعر بأن له أكثر من واحدة وهى المدبرة له فلو كان لنا نفسان لقد كنا نشعر بهما وبتدبير كل واحدة منهما فإنه لا معنى لوجود النفس في البدن إلا أنها مدبرة له ومشغولة بالنظر في أحواله لا بمعنى أنها فيه منطبعة على نحو انطباع الأعراض في الأجساموهو غير سديد فإن البدن وإن استحق لذاته نفسا فاجتماع نفسين فيه إنما يلزم أن لو كان ما يستحقه يجب أن يكون بدء وجوده مع وجوده غير منتقل إليه من بدن آخر وذلك مما لا يسلمه الخصم بل له أن يقول البدن وان استحق لذاته نفسا تدبره فلا مانع
من أن تكون هى ما انتقلت إليه من البدن الآخر وذلك لا يفضى إلى
اجتماع نفسين أصلا ولا خلاص منه
فإذا الطريق العقلى اللائق بالمنهج الفسلفى أن يقال لو قيل بانتقال النفس
من بدن إلى بدن فلا بد وأن تكون موجودة فيما انتقلت عنه أولا وإلا فوجودها
لا محالة مع وجود ما قيل إنها منتقلة إليه وإذا كانت موجودة في البدن
الأول فإما أن يكون اختصاصها به لمخصص أو لا لمخصص فإن كان لا لمخصص فليس
هو بنا أولى من غيره وإن كان لمخصص فلا بد وان يكون تخصصها بما انتقلت
إليه أيضا بمخصص كما كان اختصاصها بالأول لمخصص وعند هذا فالمخصص لها بكل
واحد من البدنين إما أن يكون واحدا أو مختلفا فإن كان واحدا فلا يخفى أن
فرض وجود البدنين معا جائز وإن استحال وجودهما معا بالفعل من حيث إن
أحدهما متقدم والآخر متأخر وعند فرض اجتماعهما إما أن توجد تلك النفس لهما
أو لأحدهما لا جائز أن تكون لهما لما سبق ولا جائز أن تكون لأحدهما لعدم
الأولوية
وعلى هذا التقسيم إن كان المخصص مختلفا فإنه إذا فرض وجود
البدنين معا فإما أن تكون النفس لهما أو لأحدهما لا جائز أن تكون لهما لما
سبق وإن كانت لأحدهما فالذى أوجب تخصصها ليس ذلك له أولى من إيجابه
لتخصصها بالبدن الآخر مع اتحاد النفس وفرض تساوى البدنين في جميع احوالهما
لضرورة تساويهما بالنسبة إليها وأن لا اولوية لأحدهما على الآخر ثم إنه
إما أن يكون مساويا لما يوجب تخصصها بالبدن الآخر أو أرجح منه في الاقتضاء
والتخصيص فإن كان مساويا فلا أولوية وإن كان راجحا فالبدن الآخر إما أن
يبقى عريا عن النفس وهو محال وإن وجد له نفس أخرى فسواء كان اختصاصها به
بذلك المخصص المرجوح أو بمخصص آخر فإنه يلزم أن يكون تنتقل إليه نفس البدن
الآخر عند فرض عدمه وذلك مفض
إلى اجتماع نفسين في بدن واحد وهو
مما لا يشعر به أحد وحصول نفس الإنسان وهو لا يشعر بها محال كما سبق وهذه
المحالات كلها إنما لزمت من فرض التناسخ
وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
فهو أن ذلك إن وقع مسلسلا إلى غير النهاية أفضى إلى القول بقدم الكائنات الفاسدات وقد عرف ما فيه وإن وقف الأمر في الابتداء على وجود نفس لبدن ما خسيس أو نفيس لم تستحقه بناء على فعل لها سابق ووقف الأمر في الانتهاء على بدن لا تستحق بعده غيره بناء على ما تفعله عند مفارقتها له فهو وان كان مقدورا لله تعالى وجائزا في العقل فالقول به مخالف لما اعتقدوه ومجانب لما أصلوه مع أنه لم يدل عليه عقل ولا ألجأ اليه نقل بل هو مخالف لما جاء به السمع ومضاد لما ورد به الشرع من أحكام المعاد وحشر الأنفس والأجساد فلا سبيل اليهوعند ذلك فلا بد من الإشارة إلى تحقيق مذهب أهل الحق في أحكام المعاد من الحشر والنشر ومساءلة منكر ونكير وعذاب القبر والصراط والميزان والجنة والنار وغير ذلك
فأما الحشر
فهو عبارة عن إعادة الخلق بعد العدم ونشئاتهم بعد الرمم وقد اختلف فيه الإسلاميونفذهبت المعتزلة على موجب أصلهم في إنقسام الأعراض إلى باقية وغير
باقية
إلى منع جواز إعادة الأعراض الغير الباقية كالحركات والأصوات ونحوها
وزعموا أنه لو تصور وجودها في وقتين يفصلهما عدم لجاز القول بوجودهما في
وقتين متتاليين وذلك في الأعراض الغير الباقية محال ومن الأصحاب من زاد
على هؤلاء لحيث منع من جواز إعادة الأعراض مطلقا وزعم أن الإعادة لمعنى
فلو جاز إعادة الأعراض للزم أن يقوم المعنى بالمعنى وهو ممتنع
ومذهب
أهل الحق من الإسلاميين أن إعادة كل ما عدم من الحادثات فجائز عقلا وواقع
سمعا ولا فرق في ذلك بين أن يكون جوهرا أو عرضا فإنه لا إحالة في القول
بقبوله للوجود وإلا لما وجد بل ما قبل الوجود في وقت كان قابلا له في غير
ذلك الوقت أيضا ومن أنشأه في الأولى قادر على أن ينشئه في الأخرى كما قال
تعالى في كتابه المبين الوارد على لسان الصادق الأمين قل يحييها الذى
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقوله وهو الذى أحياكم ثم يميتكم ثم
يحييكم إن الإنسان لكفور
وما قيل من استحالة إعادة الأعراض المتجددة
شاهدا فمأخوذ من القول باستحالة استمرارها وهو غير مسلم ثم لا يلزم من
جواز وجودها في زمنين منفصلين بينهما عدم أن يقال بوجودها
فيهما
من غير انفصال بعدم بل من الجائز أن يكون وجودها مشروطا بوقت مقدر كما
كانت مشروطة بالمحل إجماعا وسبق العدم على أصلهم مطلقا ومن قضى باستحالة
إعادة الأعراض لما فيه من قيام المعنى بالمعنى فإنما لزمه ذلك من الجهل
بمعنى الإعادة والغفلة عن معنى البعث وليس المعنى به غير الخلق ثانيا كما
في الخلق الأول وتسميته إعادة إنما كان بالإضافة إلى النشأة الأولى وذلك
مما لا يوجب قيام المعنى بالمعنى وإلا للزم القول باستحالة وجودها أولا
وهو ممتنع فإذا قد ثبت مذهب أهل الحق وفاز أهل السبق
ولم يبق إلا القول في العدم وهو أنه هل هو للجواهر والأعراض أم للأعراض
دون الجواهر
والجواب أن ذلك كله ممكن من جهة العقل وليس تعيين ذلك واقعا من ضرورة
عقلية ولا نقلية فتعيين شئ من ذلك يكون غباء
هذا حكم الحشر والنشر وعذاب القبر ومساءلته ونصب الصراط والميزان وخلق
النيران والجنان والحوض والشفاعة للمؤمن والعاصى والثواب والعقاب فكل ذلك
ممكن في نفسه أيضا وقد وردت به القواطع السمعية والأدلة الشرعية من الكتاب
والسنة وإجماع الأمة من السلف ومن تابعهم من الخلف مما اشتهاره مغن عن
ذكره فوجب التصديق به
والإذعان لقبوله والانقياد إليه والتعويل عليه على وفق ما اشتهر
عن النبى صلى الله عليه و سلم وصحابته والعلماء من أمته
فإن قال قائل من المعتزلة المقرين بالدين الخارقين لقواعد المسلمين كيف
يمكن القول بعذاب القبر ومساءلته مع أنا نرى الميت ونشاهده ولا نحس عند
وضعه في اللحد بصوت سؤال ولا جواب ولا نشاهد في حاله لا نعيما ولا عذابا
لا سيما إذا افترست لحمه الوحوش والسباع وأكلته طيور الهواء أو سمك الماء
أم كيف يمكن القول بوضع الصراط والميزان وخلق الجنة والنار في الآن فإنه
إما أن يكون ذلك كله لفائدة أو لا لفائدة فالفائدة المطلوبة من نصب الصراط
ليست إلا العبور عليه وذلك متعذر جدا بالنسبة إلى الطائع والعاص معا لكونه
كما قيل أحد من السيف وأدق من الشعرة والفائدة من نصب الميزان ليست إلا
وزن الأعمال وذلك أيضا متعذر لأنها إما أن توزن فى حال عدمها أو بعد
إعدامها القسم الأول محال جدا والقسم الثانى محال لما بيناه فيما مضى ثم
ولو قدر إعادة الأعراض المتجددة فوزنها لا محالة أيضا متعذر وحركة الميزان
بها ممتنعة وإن كانت حركة الميزان بسبب ثقل ما خلقت منه الحركة فليس ذلك
وزن الحركة وأما الفائدة في خلق الجنة والنار فليس إلا لأجل الثواب
والعقاب وذلك قبل يوم الحشر والحساب متعذر لا محالة
بل وكيف يمكن
القول بقبول الشفاعة وإثبات العفو للعاصى ومن اقترف شيئا من المعاصى وبم
الإنكار على الجبائى حيث زعم أن من زادت زلاته على طاعاته في المقدار
واخترم على الإصرار من غير توبة كان مسلوب الإيمان مخلدا في النار وبم
الرد على غيره من المعتزلة حيث أوجب ذلك باقتراف كبيرة واحدة كانت ناقصة
عن الطاعة أو زائدة أم بم الإنكار على الخوارج حيث أوجبوا التكفير بإرتكاب
ذنب واحد مستندين في ذلك إلى ما عرف من قضية إبليس وما ورد في القرآن من
الآيات الدالة على تخليد العاصى مثل قوله تعالى من كسب سيئة وأحطت بها
خطيئته فألئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد
حدوده يدخله نارا خالدا فيها وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى غير ذلك من
الآيات والدلالات الواضحات ومن استحق الخلود في النار وكان مغضوبا عليه
كيف يستحق الغفران
قلنا أما إنكار عذاب القبر مع ما اشتهر من حال
النبى صلى الله عليه و سلم والصحابة من الاستعاذة منه والخوف والحذر وقول
النبى عليه السلام حيث عبر على قبرين
فقال إنهما يعذبان وقول
الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم
تقوم الساعة أدخلوا ءال فرعون أشد العذاب فلا سبيل إليه ولا معول لأرباب
العقول عليه واستبعاد ذلك على أنه غير محسوس من الميت فمن أدرك بعقله حال
النائم في منامه و ما يناله من اللذات والتألمات بسبب ما يشاهده من حسن
وقبيح مع ما هو عليه من سكون ظاهر جسمه وخمود جوارحه بل وكذا حال المحموم
والمريض في حالة انغماره لم يتقاصر فهمه عن درك عذاب القبر ونعيمه ولا فرق
في ذلك بين أن تكون أجزاء البدن مجتمعة أو مفرقة فإن من أسكنه الألم في
حالة الاجتماع قادر أن يسكنه ذلك في حالة الافتراق وذلك لا يستدعى أن يكون
محسوسا ولا مشاهدا
وعلى هذا يخرج استبعاد سؤاله وجوابه أيضا
ومما يؤكد رفع هذا الاستبعاد ما علم من حال رسول الله صلى الله عليه و سلم
في حالة الوحى ومخاطبة جبريل له والناس حوله لا يسمعون وإنما كان كذلك لأن
الأجزاء المستقلة بالفهم والجواب من الإنسان إنما هى أجزاء باطنة يعلمها
الله تعالى في القلب فيجوز أن يخلق الله لها الحياة والفهم والجواب وإن
كان باقى الجسم معطلا لا يشعر به صاحبه وذلك كما نشاهده ونعلمه من حال
النائم والمغمى عليه لصرع أو مرض أو غيره عند مخاطبته او محاورته لمن
يتخيل له فيما هو عليه من حالته
وليس الخطاب والسؤال لمجرد الروح المفارقة التى أجرى الله تعالى العادة
بوجود
حياة البدن عند مقارنتها والفوات عند فواتها إذ هو مخالف للظواهر
الواردة
به ولا هو للبدن على هيئته إذ هو مخالف للحس والعيان وذلك محال
وإنكار الصراط والميزان وخلق الجنة والنار في الآن بناء على إنكار حصول
الفائدة فمأخوذ من أصولهم الفاسدة في وجوب الغرض في أفعال الله تعالى وقد
أبطلناه ثم ولو قدر ذلك فلعل له فيه لطفا وصلاحا لا تقف العقول عليه ولا
تهتدى الأذهان إليه بل البارى تعالى هو المستأثر بعلمه وحده لا يعلم
تأويله غيره ثم كيف ينكر جواز العبور على الصراط والمشى عليه مع أن ذلك
بالنسبة إلى مقدورات الله تعالى وخلق السموات والأرض وما فيهن والمشى في
الهواء والوقوف على الماء وشق البحر وقلب العصا حية وغير ذلك من المعجزات
والأمور الخارقة للعادات أيسر وأسهل فغير بعيد أن يخلق الله تعالى القدرة
على ذلك لما أطاعه ولا يخلقها لمن عصاه
وأما الوزن بالميزان فإنه
يحتمل أن يكون للصحف المشتملة على الحسنات والسيئات المكتوب فيها أفعال
العبد من خيره وشره ونفعه وضره ويخلق الله تعالى فيها ثقلا
وخفة
على حسب التفاوت الذى يعلمه تعالى في حسناته وسيئاته ويحتمل أن يكون ميزان
الأفعال عند الله تعالى بما يليق بالأفعال وهوالمستأثر بعلمه وحده لا على
نحو الميزان اللائق بالكميات من المدخرات والمعدودات وغيرها من الموزونات
شاهدا
وأما إنكار الشفاعة للمذنبين والعصاة من المسلمين فذلك إنما
هو فرع مذهب أهل الضلال في القول بوجوب الثواب ولزوم العقاب على الله
تعالى وقد بينا ما في ذلك من الخلل وأوضحنا ما فيه من الزلل فإن الثواب من
الله تعالى ليس إلا بفضله والعقاب ليس إلا بعدله وهو المتحكم بما يشاء في
خلقه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
وما ذكروه من
الآيات والظواهر السمعيات فمحمول على الكافرين المستحلين لما يأتونه
المستوجبين لما يقترفونه دون العصاة من المؤمنين ومن أذنب ذنبا من
المسلمين ودليل التخصيص في ذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومع قيام الدليل المخصص لها يمتنع القول
بتعميمها
فإن قيل إن هذه الآية محمولة على حالة التوبة ومخصوصة
بها وهذا وإن كان على خلاف الظاهر لكن يجب القول به محافظة على ما ذكرناه
من الظواهر إذ ليس تخصيص ما ذكرناه محافظة على الظاهر بأولى من العكس بل
هو الاولى لما فيه من تخصيص ظاهر واحد بظواهر متعددة ثم إن في الآية ما
يدل على أن المغفرة والشفاعة لا تحصل إلا أن تتعلق المشيئة بمفغرته وإلا
لما كان لتخصيص المغفرة بحالة المشيئة معنى وذلك مما يوجب خلود بعض
المذنبين وهو خلاف ما تعتقده
قلنا أما ما ذكروه من جهة التخصيص فحمل
دلالة الآية عليها ممتنع وذلك أن العفو والغفران حالة التوبة عندهم واجب
جزم ولازم حتم وهو مما يمنع تعليقه بالمشيئة وأيضا فإنه فرق في الآية بين
المعصية بالكفر وغيره في حالة التوبة فالفرق غير متحقق لا محالة فلو صح ما
ذكروه من جهة التخصيص لم يلزم تخصيص عموم الآية بما دون الكفر من المعاصى
وتأويل الظواهر لما ذكروه من الظواهر كيف وأن ما ذكروه من الظواهر فمنهم
من قيدها بفعل الكبائر دون الصغائر ومنهم من زادها تقييدا حتى اشترط في
ذلك زيادة مقدار الكبيرة على ما له من الحسنات وبالجملة فلا ريب في
تخصيصها بما بعد التوبة وليس شئ من ذلك متحققا فيما ذكرنا من الظواهر
فالمحافظة عليه يكون أولى لا سيما وأن ما من ظاهر أبدوه إلا وقد اقترن بما
يدل على تخصيصه بما نذكره فإن مخالفة جميع الحدود وتعديها وإحاطة الخطيئة
من كل وجه إنما يتحقق في حق الكافر
دون المسلم وكذلك اللعنة والغضب في حق من قتل إنما يتحقق في حق
من كان لذلك مسحلا معتقدا
وبما حققناه يقع التقصى عن كل ما يهول به من هذا القبيل وليس في تعليق
الغفران لما دون الكفران بالمشيئة ما يوجب امتناع وقوع الغفران بالنسبة
إلى جملة المذنبين بما دون الشرك ولا يلزم منه مخالفة شئ من الآية أصلا
لجواز تعلق المشيئة بالمغفرة للجميع
فإن قيل فإن استمر لكم في هذه
الظواهر ما ذكرتموه من التأويلات واستقام ما أشرتم إليه من التخصيصات فكيف
يحمل قوله عليه السلام لا ينال شفاعتى أهل الكبائر من أمتى على معصية
الكفر مع أنه قد أدرجهم في أمته وأدخلهم في ملته
قلنا هذا الحديث مع
ضعفه في سنده فليس في إضافتهم إلى ملته ما ينافى كون الكبيرة الصادرة منهم
هى الكفران والشرك بعد الإيمان فإنه قد يسمىالشئ باسم ما كان عليه تجوزا
وتوسعا وهو الأولى فإنه قد روى عن النبى صلى الله عليه و سلم بالرواية
الصحيحة المشهورة أنه قال ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى فلو لم يكن
الحديث الأول محمولا على كبيرة الكفر للزم منه تعطيل أحد
الحديثين عن
العمل به مطلقا ولا يخفى أن التعطيل أبعد من التأويل على ما لا يخفى كيف
وأن الأدلة الواردة في باب الشفاعة مع اختلاف ألفاظها أكثر من أن تحصى فهى
إلى التمسك بها أقرب وأولى فمن ذلك ما روى عن النبى صلى الله عليه و سلم
في أثناء حديث مطول مشهور أنه قال إذا كان يوم القيامة أخر ساجدا بين يدى
ربى فيقول لى يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتى أمتى
فيقال انطلق من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأخرجه وأنطلق وأخرجه ثم
أسجد ثانية وثالثة فإذا كان الرابعة قلت رب ائذن لى فيمن قال لا إله إلا
الله فيقول الرب وعزتى وجلالى لأخرجن منها كل من قال لا إله إلا الله وهو
حديث مروى في الصحاح
وأما القضاء بانتفاء إيمان من اخترم عاصيا قبل
التوبة والقول بتكفيره فالانفصال عنه يستدعى تحقيق معنى الإيمان والكفران
والكشف عن معنى التوبة وتحقيق الأوبة
وأما الإيمان فهو في اللغة
عبارة عن التصديق ومنه قول بنى يعقوب وما أنت بمؤمن لنا أى بمصدق وفي عرف
استعمال أهل الحق من المتكلمين عبارة عن التصديق بالله وصفاته وما جاءت به
أنبياؤه ورسالاته وإليه الإشارة بقوله عليه السلام الإيمان هو التصديق
بالله وباليوم الآخر كأنك تراه فمن وفقه الله لهذا التصديق
وأرشده إلى هذا
التحقيق فهو المؤمن الحق عند الله وعند الخلق وإلا فقد شقى الشقاوة الكبرى
وحكم بكفره في الدنيا والأخرى لأن الكفر وإن كان في اللغة عبارة عن
التغطية والستر فهو فى عرف أهل الحق من المتكلمين عبارة عن الستر والتغطية
للقدر الذى يصير به المؤمن مؤمنا لا غير وليس الإيمان هو الإقرار باللسان
فقط كما زعمت الكرامية ولا إقامة العبادات والتمسك بالطاعات كما زعمت
الخارجية فإنا نعلم من حال النبى صلى الله عليه و سلم عند إظهار الدعوة
انه لم يكتف من الناس بمجرد الإقرار باللسان ولا العمل بالأركان مع تكذيب
الجنان بل كان يسمى من كانت حاله كذلك كاذبا ومنافقا ومنه قوله تعالى
تكذيبا للمنافقين عند قولهم نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين
لكاذبون ومنه أيضا شهادة الكتاب العزيز بكذبه وسلب إيمانه في قوله ومن
الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما ورد في
الكتاب والسنة وأقوال الأمة في ذلك أكثر من أن يحصى
ثم لا يخفى قبح
القول بأن الإيمان مجرد الإقرار باللسان من حيث إفضائه إلى تكفير من لم
يظهر ما أبطنه من التصديق والطاعة وامتناع استحقاقه للشفاعة والحكم
بنقيضه لمن أظهر ضد ما أبطن من الكفر بالله تعالى ورسوله
والطغاوة في
الدين والعداوة للمسلمين بل أشد قبحا منه جعل الإيمان مجرد الإتيان
بالطاعات والتمسك بالعبادات لما فيه من الإفضاء إلى هدم القواعد السمعية
وحل نظام الأحكام الشرعية وإبطال ما ورد في الكتاب والسنة من جواز خطاب
العاصى بما دون الشرك قبل التوبة بالعبادات البدنية وسائر الأحكام الشرعية
وصحتها منه أن لو أتى بها وبإدخاله في زمرة المؤمنين وإدراجه في جملة
المسلمين حتى إنه لو مات فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين
ولو لم يكن مؤمنا لما جاز القول بصحة ما أتى به من العبادات ولا غير ذلك
مما عددناه
وبهذا يتبين أيضا فساد قول الحشوية إن الإيمان هو
التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان نعم لا ننكر جواز إطلاق
اسم الإيمان على هذه الأفعال وعلى الإقرار باللسان كما قال تعالى وما كان
الله ليضيع إيمانكم أى صلاتكم وقوله عليه السلام الإيمان بضع وسبعون بابا
أولها شهادة أن لا إله إلا الله وآخرها إماطة الأذى عن الطريق لكن إنما
كان ذلك لها من جهة أنها دالة على التصديق بالجنان
ظاهرا والعرب
قد تستعير اسم المدلول لدليله بجهة التجور التوسع كما تستعير اسم السبب
لمسببه فعلى هذا مهما كان مصدقا بالجنان على الوجه الذى ذكرناه وإن أخل
بشئ من الأركان فهو مؤمن حقا وانتفاء الكفر عنه واجب وإن صح تسميته فاسقا
بالنسبة إلى ما أخل به من الطاعات وارتكب من المنهيات ولذلك صح إدراجه في
خطاب المؤمنين وإدخاله في جملة تكليفات المسلمين بقوله وأقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة ونحو ذلك من الآيات
وقوله عليه السلام لا يسرق السارق
حين يسرق وهو مؤمن ولا يزنى حين يزنى وهو مؤمن فإنه وإن صح لم يصح حمله
على نفى الإيمان بمعنى الطاعة والإذعان لتعذر الاشتقاق من اسم أيمان
فيحتمل أنه أراد حالة الاستحلال ويحتمل أنه أورده في معرض المبالغة في
الزجر والردع وهو وإن كان خلاف الظاهر لكنه أولى لما فيه من الجمع بينه
وبين ما ذكرناه من الأدلة الدالة على كونه مؤمنا وإبطال التعطيل لما
ذكرناه مطلقا نعم لا ننكر إمكان دخول الشك والريبة لما يحصل من التصديق
بالجنان ثابتا بالنسبة إلى من ليس بمعصوم بناء على شبهة وخيال ولذلك كان
بعض السلف يقول أنا مؤمن إن شاء الله وليس المراد بما علقه على المشيئة
إلا استمرار ما هو حاصل عنده عند الله من التصديق والطمأنينة لا نفس
التصديق الحاصلة فإن تعليق
ما حصل بالمشيئة محال ولا بد من هذا
التأويل وإن فسر الإيمان بالطاعة أو القول أيضا وبهذا الاعتبار ايضا يصح
القول بزيادة إيمان النبى المعصوم على إيمان غيره أى من جهة تطرق الشك إلى
غير المعصوم دون المعصوم أما أن يكون من جهة تطرق الزيادة والنقصان إليه
من حيث هو تصديق فلا كما لا يصح ذلك بين علم وعلم أصلا
وأما التوبة
فهى وإن كانت في اللغة عبارة عن الرجوع فهى في عرف استعمال المتكلمين
عبارة عن الندم على ما وقع به التفريط من الحقوق من جهة كونه حقا ومنه
قوله عليه السلام الندم توبة فعلى هذا من ترك المعصية من غير عزم على ترك
معاودتها عند كونه لذلك أهلا والندم والتألم على ما اقترف أولا من جهة أنه
لم يكن له ذلك مستحقا لم يكن إطلاق اسم التوبة في حقه بالنظر إلى عرف
المتكلمين مما يجوز لكن ذلك مما لا يجب على العبد استدامته في سائر أوقاته
وتذكره في جميع حالاته وإلا لزم منه اختلال الصلوات أو لا يكون تائبا في
بعض الأوقات وهو خلاف
إجماع المسلمين وليس من شرط صحة التوبة
والإقلاع عن ذنب في زمن من الأزمان ألا يعاوده في زمن آخر إذ التوبة مهما
وجدت فهى عبادة ومأمور بها وليس من شرط صحة العبادة المأتى بها في زمن ألا
يتركها في زمن آخر
وليس من شرط صحة التوبة أيضا والاقلاع عن ذنب
الإقلاع عن غيره من الذنوب كما زعم أبو هاشم وإلا كان من أسلم بعد كفره
وآمن بعد شقائه ونفاقه إذا استدام زلة من الزلات وهفوة من الهفوات ألا
يكون مقلعا عما التزمه من أوزار كفره وألا يترقى على من هو على غيه وجحوده
وذلك مما يخالف إجماع المسلمين وما ورد به الشرع المنقول واتفق عليه أرباب
العقول
وبهذا يندفع قول القائل إن ما وجبت التوبة عنه فإنما كان
لقبحه وذلك لا يختلف فيه ذنب وذنب فلا يصح الندم على قبيح مع الإصرار على
قبيح غيره
والله الهادى إلى الرشاد
القانون السابع
فى النبوات والأفعال الخارقة للعاداتويشتمل على طرفين
تمهيد
الطرف الأول من هذا القانون في بيان جوازها في العقل
والثانى في بيان وقوعها بالفعل
وقبل الخوض فى ذلك لا بد من تفسير معنى النبوة لكى يكون التوارد بالنفى
والاثبات على محز واحد فنقول
ليست النبوة هى معنى يعود إلى ذاتى من ذاتيات النبى ولا إلى عرض من أعراضه
استحقها بكسبه وعمله ولا إلى العلم بربه فإن ذلك مما يثبت قبل النبوة ولا
إلى علمه بنبوته إذ العلم بالشئ غير الشئ ولكن الله يمن على من يشاء من
عباده فليست إلا موهبة من الله تعالى ونعمة منه على عبده وهو قوله لمن
اصطفاه واجتباه إنك رسولى ونبيى
وإذا عرف محز الخلاف فنعود إلى بيان الأطراف
1 - الطرف الاول في بيان الجواز العقلى
مذهب أهل الحق أن النبوات ليست واجبة أن تكون ولا ممتنعة أن تكون بل الكون
وأن لا كون بالنسبة إلى ذاتها و إلى مرجحها سيان وهما بالنظر إليه سيان
وأما أهل الطعان فحزبان حزب انتمى إلى القول بالوجوب عقلا كالفلاسفة
والمتعزلة
وحزب انتمى إلى القول بالأمتناع كالبراهمة والصابئة
والتناسخية إلا أن من البراهمة من اعترف برسالة آدم دون غيره ومنهم من لم
يعترف بغير ابراهيم وأما الصابئة فإنهم اعترفوا برسالة شيث وإدريس دون
غيرهما ولا بد من التفصيل في الرد على أهل التضليل
فأما الفلاسفة والمعتزلة
فإنهم قالوا لما كان نوع الإنسان أشرف موجود فى عالم الكون لكونه مستعدا
لقبول
النفس الناطقة القريبة النسبة من الجواهر الكروبية والجواهر
الروحانية لم
يكن في العقل بد من حصول لطف المبدأ الأول وإضافة الجود منه عليهم لتتم
لهم النعمة في الدنيا والسعادة في الأخرى وكل واحد من الناس قلما يستقل
بنفسه وفكرته وحوله وقوته فى تحصيل أغراضه الدنياوية ومقاصده الآخروية إلا
بمعين ومساعد له من نوعه وإذ ذاك فلا بد من أن تكون بينهم معاملات من عقود
بياعات وإجارات ومناكحات إلى غير ذلك مما تتعلق به الحاجات وذلك لا يتم
إلا بالإنقياد والاستسخار من البعض للبعض و قلما يحصل الانخضاع والانقياد
من المرء لصاحبه بنفسه مع قطع النظر عن مخوفات ومرغبات دينية وأخروية وسنن
يتبعونها وآثر يقتدون بها وذلك كله إنما يتم ببيان ومشرع يخاطبهم ويفهمهم
من نوعهم وفاء بموجب عناية المبدأ الأول بهم
ثم يجب أن يكون البيان
مؤيدا من عند الله تعالى بالمعجزات والأفعال الخارقة للعادات التى تتقاصر
عنها قوى غيره من نوعه بحيث يكون ذلك موجبا لقبول قوله والانقياد له فيما
يسنه ويشرعه ويدعو به إلى الله تعالى وإلى عبادته والانقياد لطاعته وما
الله عليه من وجوب الوجود له وما يليق به وما لا يليق به وأحكام المعاد
وأحكام المعاش ليتم لهم النظام ويتكامل لهم اللطف والإنعام وذلك كله
فالعقل يوجبه لكونه حسنا ويحرم انتفاءه لكونه قبيحا
وأعلم ان
مبنى هذا الكلام إنما هو على فاسد أصول الخصوم في الحسن والقبح ورعاية
الصلاح والأصلح ووجوبه وقد سبق إبطاله بما فيه مقنع وكفاية
وأما الغلاة من النفاة
الجاحدين لوجوب الوجود فإنهم قالوا النبوة ليست من صفة راجعة إلى نفس
النبى بل لا معنى لها الا التنزيل من عند رب العالمين وعند ذلك فالرسول لا
بد له أن يعلم أنه من عند الله تعالى وذلك لا يكون الا بكلام ينزل عليه أو
بكتاب يلقى إليه إذ المرسل ليس بمحسوس ولا ملموس وما الذى يؤمنه من أن
يكون المخاطب له ملكا او جنيا وما ألقى إليه ليس هو من عند الله تعالى ومع
هذه الاحتمالات فقد وقع شكه في رسالته وامتنع القول الجزم بنبوته
ثم
إن ما يكلمه وينزل عليه إما أن يكون جرمانيا أو روحانيا فإن كان جرمانيا
وجب أن يكون مشاهدا مرئيا وإن كان روحانيا فذلك منه مستحيل كيف وأن ما جاء
به لم يخل إما أن يكون مدركا بالعقول أو غير مدرك بها فإن كان الأول فلا
حاجة إلى الرسول بل البعثة تكون عبثا وسفها وهو قبيح في الشرع وإن كان
الثانى فما يأتى لا يكون مقبولا لكونه غير معقول فالبعثة على كل حال لا
تفيد
وأيضا فإن النفوس الإنسانية كلها من نوع واحد فوجب أن يستقل
كل منها بدرك ما أدركته الأخرى ولا تتوقف على من يحكم عليها فيما تهتدى
إليه وما لا تهتدى إليه فإن ذلك مما يقبح من الحكيم عقلا
ومما يدل
على العبث في بعثته تعذر الوقوف على صدق مقالته فإن وجوب التصديق له بنفس
دعواه مع ان الخبر ما يصح دخول الصدق والكذب فيه مستحيل وإن كان بأمر خارج
إما بأن تقع المشافهة من الله تعالى بتصديقه أو باقتران أمر ما بقوله يدل
على صدقه فهو أيضا مستحيل إذ المشافهة من الله تعالى بالخطاب متعذرة ولو
لم تكن متعذرة لاستغنى عن الرسول وما يقترن بقوله إما أن يكون مقدورا له
أو لله تعالى فإن كان مقدورا له فهو أيضا مقدور لنا فلا حجة له في صدقه
وان كان مقدورا لله تعإلى فإما أن يكون معتادا أو غير معتاد فإن كان معتاد
فلا حجة فيه أيضا وإن كان غير معتاد بأن يكون خارقا للعادات فليس في ذلك
ما يدل على صدقه في دعوته إذ هو فعل الله تعالى وهو مشروط بمشيئته وتخصصه
منوط بإرادته وربما لا يتصور في جميع الحالات ولا يساعد في سائر الأوقات
وكم من نبى سأل إظهار المعجزات في بعض الأوقات فلم يتفق له ما سأله فإذا
كان كذلك فلعل اقترانها بدعوته في بعض الاوقات كان من قبيل الاتفاقات لا
بقصد التصديق له فيما يقوله والتحقيق له
ثم إن كان ظهور هذه الآيات و اقترانها بقوله في بعض الأوقات دليلا على
فعدم اقترانها به فى بعض الأوقات دليل على كذبه وليس أحد الأمرين
بأولى من
الآخر والذى يدل على ذلك أنا ألفينا كل مدع قد اباح ما تحظره العقول مثل
ذبح الحيوان وإيلامه وتسخيره ومثل السعى بين الصفا والمروة والطواف بالبيت
وتقبيل الحجر والعطش فى أيام الصيام والمنع من الملاذ التى بها صلاح
الأبدان وذلك كله قبيح والقبيح لا يأمر به الحكيم فهم فيما ادعوه كاذبون
وفيما انتحوه متخرصون
ثم وإن قارنت لدعواه في جميع الأوقات ولم توجد
فى غيرها من الحالات فهى مما لا تمييز فيها عن الكرامات والسحر والطلسمات
وغير ذلك من العلوم كالسحر والتنجيم من الأفعال العجيبة والأمور المعجزة
الغريبة التى لا وقوع لها فى جميع الاوقات ولا سبيل إليها في سائر الحالات
بل هى على نمط المعجزات والأمور الخارقة للعادات ومع جواز أن يكون ما أتى
به من هذا القبيل فليس على القول بصدقه تعويل
ثم وان تميز ما أتى به
عن هذه الأحوال وتجرد عن هذه الأفعال فلا محالة أن من أصلكم جواز انقلاب
العوائد واطراد ما لم يعهد وعند اطرادها فلا يخفى أنها تخرج عن أن تكون
معجزة لكونها لا اختصاص لها به وإذا كان كذلك فما الذى يؤمننا من اطراد
معجزته وعموم وقوعها بعد تحديه بنبوته
ثم ولو قدر عدم اطرادها فذلك
أيضا مما لا يدل على صدقة بل لعله كاذب في دعوته والبارى تعالى مريد
لضلالنا برسالته وأن ما يدعو اليه من الخير هو عين الشر وما ينهى
عنه من الشر هو عين الخير فإنه لا إحالة فيه على أصلكم حيث
أحلتم كون الحسن والقبح ذاتيا
ثم وإن استحال ذلك فى حق الله تعالى فلا محالة أن العلم برسالة الرسول
والقول بتصديقه يتوقف على معرفة وجود المرسل وصفاته وما يجوز عليه وما لا
يجوز بتوسط الحادثات والكائنات والممكنات وذلك كله ليس هو مما يقع بديهة
فإنه لو خلى الانسان ودواعى نفسه في مبدأ نشوئه من غير التفات إلى أمر آخر
لم يحصل له العلم بشئ من ذلك أصلا فعند إرسال الرسول إما أن يجوز للمرسل
اليه النظر والابتهال بالفكر والاعتبار بالعبر أو لا يجوز له ذلك فإن قيل
بالجواز فلا يخفى أن زمان النظر غير مقدر بقدر بل هو مختلف باختلاف
الاحوال والاشخاص وتقلب أحوالهم والاشتداد والضعف في أفهامهم وذلك مما
يفضى إلى تعطيل النبى عن التبليغ لرسالاته وافحامه في دعوته ولا فائدة إذ
ذاك فى بعثته وإن لم يمهل فى النظر فذلك قبيح لا محالة من جهة أنه كلفه
التصديق بما لا يطيق أوجب عليه التقليد والانقياد من غير دليل إلى
الاعتقاد وذلك قبيح لا تستحسنه العقول
ثم إنه إما أن يكون مرسلا إلى
من علم الله أنه لا يؤمن أو لا يكون مرسلا إليه فإن كان مرسلا إليه
فالعقاب على مخالفته ظلم وهو قبيح من الحكم العدل
وزادت التناسخية على هؤلاء فقالوا
الأفعال الانسانية إن كانت على منهاج قويم وسنن مستقيم ارتفعت نفس فاعلها
إلى الملكوت بحيث تصير نبيا أو ملكا وإن كانت أفعاله على منهاج أفعال
الحيوانات والتشبه بالسفليات والانغماس في الرذائل والشهوات
انحطت نفسه
إلى درجة الحيوانات أو أسفل منها وهكذا على الدوام كلما انقضى عصر ودور
وليس ثم عالم جزاء ولا حساب ولا كتاب ولا حشر ولا عقاب وذلك كله مما عرف
بالعقول على طول الدهر فلا حاجة بالإنسان إلى من هو مثله يحسن له فعلا أو
يقبح له فعلا إذ لا يزال فى فعل يجزى أو فى جزاء على فعل وهكذا على الدوام
والطريق
في الانفصال عن كلمات أهل الضلال أن يقال أما ما أشاروا
إليه من تعذر علمه بمرسله فبعيد إذ لا مانع من أن يعلمه المرسل له أنه هو
الله تعالى وذلك بأن يجعل له على ذلك آيات ودلائل ومعجزات بحيث تتقاصر
عنها قوى سائر الحيوانات المخلوقات أو بأن يكون ما أنزل إليه وألقى عليه
يتضمن الإخبار عن الغائبات والأمور الخفيات التى لا يمكن معرفتها إلا
لخالق البريات أو بأن يخلق له العلم الضروري بذلك إن الله على كل شئ قدير
وليس المطلوب لهذا الشخص من قبل الله تعالى بمستحيل ولا نزول الوحى
إليه مع الأمين جبريل فإنه غير بعيد أن تشمله العناية من المبدأ
الأول
بتكميل فطرته وتصفية جوهر نفسه وتنقيته بحيث يتهيأ لقبول هذه الأسرار
ويستعد لدرك هذه الأنوار فيرى ملائكة الله على صور مختلفة ويسمع وحيها
وحدة دون غيره من الحاضرين ويختص به دونهم أجمعين إن الله تعالى يصطفى من
الملئكة رسلا ومن الناس
وليس ما يراه النبى من اختلاف صور الملك
لتبدل حقيقته أو لتبدل صورته وشكله بل الذى يظهر أنها أنوار روحانية
وجواهر عقلية تظهر فى الخيال على اختلاف تلك الأشكال ويكون تعلقها به فى
ضرب المثال على نحو تعلق الأنفس الناطقة بالأبدان فإذا اشتد صفاء نفسه
بحيث صارت متصلة بعالم الغيب انطبعت تلك الأشكال في القوة الخيالية
وارتقمت فيها تلك الكمالات اللاهوتية ثم انطبع ما حصل فى الخيال من
الإدراكات الظاهرة في الحواس الباطنة فإذا ذاك يرى من الأشخاص والصور
ويسمع من الأصوات ما تتقاصر عن الإحاطة به قوى البشر فما يراه من الصور هى
ملائكة الله وما يسمعه من الكلام هو كلام الله ووحيه الموحى به إليه
وأقرب مثال يقربه الى الذهن ويصوره فى الوهم ما نشاهده فى بعض الناس فإنه
قد يقل شواغله البدنية وينصرف عن اشتغاله بمتعلقات حواسه الظاهرة بسبب
يبوسة تغلب على مزاجه أو لأمر ما بحيث يصير كالمبهوت وحينئذ قد يرى من
الصور ويسمع من الأصوات حسب ما يراه النائم فى منامه وإن كان مستيقظا بل
ومثل هذا قد وجد لبعض المرضى والمصروعين وبعض المتكهنين والمقصود من هذا
إنما هو التقريب بالمثال وإلا فهذه صفة نقص والأولى صفة تمام وكمال
وما أشير إليه من الشبهة الثانية فمندفعة وذلك أنه لا مانع من أن يرد
النبى بما هو في نفسه معقول ويكون تحذيره وترغيبه تأكيدا ويكون ذلك بمثابة
إقامة أدلة متعددة
المدلول واحد وهو لا يسمى عبثا كيف وإنا قد بينا ان العبث
والقبح منفى عن واجب الوجود في جميع افعاله
ثم نقول إن الرسول لا يأتى إلا بما لا تستقل به العقول بل هى متوقفة فيه
على المنقول وذلك كما في مسالك العبادات ومناهج الديانات والخفى مما يضر
وينفع من الأقوال والأفعال وغير ذلك مما تتعلق به السعادة والشقاوة فى
الأولى والأخرى وتكون نسبة النبى إلى تعريف هذه الأحوال كنسبة الطبيب إلى
تعريف خواص الادوية والعقاقير التى يتعلق بها ضرر الأبدان ونفعها فإن عقول
العوام قد لا تستقل بدركها وإن عقلتها عندما ينبه الطبيب عليها وكما لا
يمكن الاستغناء عن الطبيب في تعريف هذه الأمور مع أنه قد يمكن الوقوف
عليها والتوصل بطول التجارب إليها لما يفضى إليه من الوقوع في الهلاك
والأضرار لخفاء المسالك فكذلك النبى وبهذا التحقيق يندفع ما وقعت الإشارة
إليه من الشبهة الثالثة أيضا
فإن قيل إن تخصيص هذا الشخص بالتعريف
دون غيره من نوعه ميل إليه وحيف على غيره وهو قبيح قلنا فعلى هذا يلزم
التسوية بين الخلائق فى أحوالهم وألا تفاوت بين أفعالهم بحيث لا يكون هذا
عالما وهذا جاهلا ولا هذا زمنا وهذا ماشيا ولا هذا أعمى وهذا بصير إلى غير
ذلك من أنواع التفاوت في الكمالات وحصول الملاذ والشهوات وإلا عد
ذلك منه قبيحا وهو محال لكنه واقع فإذا ما هو الاعتذار ههنا
للخصم هو الاعتذار بعينه لنا في محز الخلاف
وأما ما ذكروه من تعذر الوقوف بالعقول على صدق الرسول فتصريح بتعجيز الله
تعالى عن تصديق من اصطفاه ونبأه واتخذه وسيلة إلى إصلاح نظام الخلق
بالإرشاد إلى السبيل الحق كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
بل من له الخلق والأمر وله التصرف فى عباده بالبذل والمنع والشطر والجمع
كما كان قادرا على تعريف الخلائق بنفس ربوبيته والتصديق بإلهيته قادر على
أن يعرفهم صدق من اصطفاه واجتباه لحمل أمانته إما بأن يخلق لهم علما
ضروريا بذلك أو بالإخبار عن كونه رسولا كما قال تعالى فى حق آدم للملائكة
إنى جاعل فى الأرض خليفة ولا يلزم من تصور الخطاب من المرسل الاستغناء عن
الرسول فإن ذلك حجر وتحكم على الحاكم فى مملكته وهو خلاف المعقول بل لله
تعالى أن يصطفى من عباده الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس
وقد
يكون التعريف للصدق بإظهار المعجزات على يد مدعى النبوات على وجه تدين له
العقول السليمة بالإذعان والقبول وذلك أنه إذا قال أنا رسول وآية صدقى في
قولى إتيانى بما لا تستطيعون الإتيان بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا من
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وشق البحر وقلب العصا حية وغير ذلك من
الآيات فإذا ما ظهر ذلك على يده مقارنا لدعوته قطع كل عقل سليم ولب مستقيم
بتصدقيه فى قوله وتحقيقه وأذعن إلى اتباعه وتقليده إذ العقل الصريح يقضى
بأن ظهور الخارق للعادة مقارنا لدعوته وعجز الناس عن معارضته مع توفر
دواعيهم على
مقابلته وإفحامه فى رسالته ينهض دليلا قاطعا على صدق
مقالته وإظهار البارى تعالى ذلك على يده مقارنا لدعوته ينزل منزلة الخطاب
إنه رسول وإنه صادق فيما يقوله إذ لو كان ذلك اتفاقا لما وقع على وفق
إخباره وعلى حسب إيثاره واختياره إذ هو ممتنع بالنظر إلى الاستحالة
العادية ولا سيما إن وقع ذلك منه متكررا
وليس ذلك فى ضرب المثال إلا
كما لو كان بعض الملوك جالسا فى رتبته قاعدا على سرير مملكته والناس
مجتمعون لخدمته قياما فى طاعته فقام واحد من عرض الناس وقال يأيها الناس
إنى رسول هذا الملك إليكم بكذا وكذا وآية صدقى على ذلك أنى إذا طلبت منه
أن يقوم ثلاث مرات أو يحرك كفه أو يده مثلا فعل ولو أراد واحد منكم لم يجد
إليه سبيلا فإنه إذا أتى له بذلك لم يتمار أحد من الحضور ولا يداخله شك أو
فتور أنه صادق فيما ادعاه حقيق فيما أتاه
والذى يؤكد ذلك إسناد
تصديقه إلى متوقف على مشيئة البارى تعالى وإرادته دون مشيئته هو إرادته
سرعة اقترانها بدعوته وإلا فلو كانت المعجزة مستندة إلى حوله وقوته لم
ينتهض من ذلك دليل على كونه رسول رب العالمين فإنه لم ينزل اقتران المعجزة
بدعواه منزلة التصديق له من الله تعالى كما إذا كانت المعجزة من خلق الله
وفعله وداخلة تحت مشيئته وحوله والمكابر لذلك جاحد لما أنعم الله عليه من
العقل السنى والنطق النفسانى
وبعد ما تقترن المعجزة بدعواه على سبيل
ما يجريه الله ويثبت صدقه فى ذلك بطريق العلم بناء على ما احتفت به من
القرائن الظاهرة والدلائل الباهرة فلا ينتهض عدمها بعد ذلك دليلا على كذبه
وإبطاله رسالته وإلا لوجب أن ينقلب العلم جهلا
وذلك محال وليس
انتفاء دليل الإثبات فى بعض الأوقات دليلا على إيجاب النفى بخلاف دلالته
فى حالة الإثبات فلا تعارض وعليك بمراعاة هذه الدقيقة والإشارة إلى هذه
الحقيقة
فإن قيل تعلق العلم بتصديق مثل هذا في الشاهد ينبنى على
قرائن الأحوال كالأفعال والأقوال من المرسل وذلك مما يتعذر الوقوف عليه في
حق الغائب فلا يصح التمثيل ثم وإن صح ذلك فى حق الغائب وأن ذلك نازل منه
منزلة التصديق بالقول لكن ذلك إنما يدل على صدقه أن لو استحال الكذب فى
حكم الله تعالى وذلك إما أن يدرك بالعقل أو السمع لا سبيل إلى القول
باستحالته عقلا إذ قد منعتم أن يكون الحسن والقبح ذاتيا ولا سبيل إلى
إدراكه بالسمع إذ السمع متوقف على صحة النبوة متوقفة على استحالة الكذب فى
حكم الله فلو توقف ذلك على السمع كان دورا ممتنعا
قلنا المقصود من
ضرب المثال ليس إلا تقريب الصور من الخيال وإلا فالعلم بصدق المتحدى
بالنبوة عند اقتران المعجز الخارق للعادة بدعواه واقع لكل عاقل بالضرورة
فإنه إذا قال أنا رسول خالق الخلق إليكم ويعضد ذلك بما يعلم أنه لا يقدر
على إيجاده أحد من المخلوقين ولا يتمكن من إحداثه شئ ما الحادثات علم أن
مبدعه وصانعه ليس إلا مبدع العالم وصانعه وذلك عند كل لبيب أريب منزل
منزلة التصديق له بالقول على نحو ما ضربناه من المثال ومن جرد نظره إلى
هذا القدر من الاستدلال في الشاهد أيضا وجد من نفسه أن المدعى صادق فى
المقال وإن قطع النظر عن قرائن الأحوال
ولهذا فإن من كان غائبا
من مجلس الملك ولم يشاهد عرشه ولا حالة من الأحوال لو نظر إلى مجرد هذا
أوجب ذلك عنده التصديق والتحقيق من غير التفات إلى شئ غيره
وأما ما
ذكروه فى تطرق الكذب إلى حكم الله تعالى فتهويل ليس عليه تعويل لكن من
الاصحاب من قال فى الجواب إن إثبات الرسالة مما لا يفتقر إلى نفى الكذب عن
الله تعالى فى حالة الإرسال فإنه لا يتوقف تصحيح الرسالة على الإخبار بأنه
رسول فى الماضى حتى يصح أن يدخله الصدق والكذب بل إظهارالمعجزة على يده
واقترانها بدعوته ينزل منزلة الإنشاء لذلك والأمر به وجعله رسولا فى الحال
وهو كقول القائل وكلتك فى أمرى واستنبتك فى أشغالى وذلك مما لا يستدعى
تصديقا ولا تكذيبا
وهو غير مرضى فإن المعجزة لو ظهرت على يد شخص لم
يسبق منه التحدى لم تكن آية في النبوة ولا دليلا له فى الرسالة إجماعا فلو
كان ظهور المعجزة على يده ينزل منزلة الإنشاء للرسالة والأمر بالبعثة لوجب
أن يكون مثل هذا هنا وليس كذلك وإذا لم يكن بد من القول بالتحدى علم أن
ذلك ليس ينزل منزلة الانشاء المطلق بل لا بد فيه من الخبر لتصديقه فيما
أخبر به أنه نبى ورسول لضرورة اشتراط التحدى سابقا والتصديق بذلك والعلم
به مع قطع النطر عن بيان استحالة الكذب في حق الله تعالى محال
والذى
يخمد تأثره هذا الإشكال ويقطع دابر هذا الخيال وإن كان عند الإنصاف فى
التحقيق عويصا هو أن يقال إن القول باستحالة الكذب فى حق الله تعالى مما
لا يستند إلى سمع ولا إلى التحسين والتقبيح وإن حصر مدرك ذلك في هذين باطل
بل المدرك فى ذلك أن يقال قد ثبت كون البارى تعالى عالما متكلما
وأن كلامه فى نفسه واحد وذلك لا يقبل الصدق والكذب وإنما يقبل
ذلك من جهة
كونه خبرا والخبرية له من جهة متعلقه لا غير فلو تعلق خبره بشئ ما على
خلاف ما هو عليه لم يخل إما أن يكون ذلك فى حالة الغفلة والذهول أو مع
العلم به فإن كان مع الغفلة فيلزم منه إبطال الدليل القاطع على كونه عالما
وإن كان ذلك مع العلم به على ما هو عليه فلا محالة ان تعلق الخبر بما هو
معلوم غير مستحيل بل واجب على نحو تعلق الإرادة والقدرة بمتعلقاتها كما
بيناه وعند ذلك فلو تعلق الخبر بالمعلوم على خلاف ما هو عليه لم يخل إما
أن يصح تعلق الخبر به على ما هو عليه أو لا يصح فإن لم يصح فهو محال وإن
صح لزم منه جواز تعلق الخبر بشئ واحد على ما هو به وعلى خلاف ما هو به وهو
محال إذ الخبر يستدعى مخبرا عنه إذ الخبر ولا مخبر محال وإذا استدعى مخبرا
فالواجب أن يكون متصورا فى نفسه فإن تعلق الخبر بمخبر غير متصور نازل
منزلة الخبر ولا مخبر وعند ذلك فلا يخفى أن المخبر عنه ههنا غير متصور إذ
الجمع بين الشئ ونقيضه محال فلا يتصور أن يقوم بنفس القائل الإخبار عنه
فلو تعلق خبر البارى تعالى بالشئ على خلاف ما هو عليه للزم منه هذا المحال
وهو ممتنع وهذا ظاهر لا مراء فيه ولا شبهة أو ظن يعتريه وإذا ثبت امتناع
قيام الخبر الكاذب بنفس البارى وأن إظهار المعجزة على يد النبى نازل منزلة
الإخبار بالتصديق فلو لم تكن دالة على وفق ما قام بالنفس من الخبر الصادق
وإلا لما كانت نازلة منزلة التصديق وهو ممتنع لما سبق
وأما ما ذكروه
من جواز اطرادها وإظهارها على يد غيره أو يده فذلك مما لا يقدح فى دلالتها
على صدقه وأن اقترانها بدعوته وهى من قبيل الخوارق للعادات نازل منزلة
التصديق له فيما يقوله ويتحدى به بحيث تركن النفوس إليه وتطمئن القلوب بما
دعا إليه من غير مداخلة شك ولا ريب فإنه لم يتحد بأن معجزته مما لا تطرد
ولا مما لا تظهر على يد غيره وإنما تحدى بما هو الخارق واقترانه
بدعوته
ووقوعه على وفق مقالته وإرادته وذلك كما إذا قال أنا رسول وآية صدقى نزول
المطر فى هذه الحالة وليس ثم غيم ولا تصاعد أبخرة ولا علامة دالة على نزول
المطر فإنه إذا نزل المطر كان ذلك آية صدقه من حيث وقوعه على وفق مقالته
وعدم دخوله تحت قدرته وإن كان نزول المطر فى نفسه ليس بخارق ولا نادر
وكذلك الكلام فى حق كل من ظهر هذا الخارق على يديه مقترنا بالتحدى فإنه
يجب القول بتصديقه في قوله والأجابة لدعوته نعم ان تصور منه التحدى
والإخبار بأن آية صدقه أن ما ظهر على يده لا يظهر على يد غيره فإن معجزته
لا تتم إلا بعدم ظهور ذلك إلا على يده إذ الإعجاز ليس إلا فيه فإن ظهر على
يد غيره فإن ذلكم لا يكون آية على صدقه بل يتبين به كذبه فى مقالته
وأما الإشارة إلى عدم تمييز المعجزة عن الكرامات والسحر والطلسمات وغير
ذلك من الامور العجيبات فالجواب الإجمالى فيه هو أن ادعاء أن كل مقدور لله
تعالى مما يمكن تأتيه بهذه الأمور مما يعلم بطلانه بالضرورة فإن أحدا من
العقلاء لا يجوز انتهاء السحر والطلسم وغيره من الصنائع إلى فلق البحر
وإحياء الميت وإبراء الاكمه والأبرص
وإن قيل بالتفاوت فقد جوز من
جهة العقل تصور تصديق للرسول بما لا يتأتى من السحر ولا بغيره وهو ما وقع
مقصودنا ههنا وليس تشوفنا إلا للفرق من جهة التفصيل فيسدعى ذلك تحقيق
المعجزة وبيان خواصها التى لا يشاركها فيها غيرها فنقول
المعجز
فى الوضع مأخوذ من العجز وهو فى الحقيقة لا يطلق على غير البارى تعالى
لكونه خالق العجز وإن سمينا غيره معجزا كما فى فلق البحر وإحياء الموتى
فذلك إنما هو بطريق التجوز والتوسع من كونه سبب ظهور الإعجاز وهو الإنباء
عن امتناع المعارضة لا الانباء عن العجز عن الإتيان بمثل تلك المعجزة كما
يتوهمه بعض الناس فإن ذلك مما لا يتصور العجز عنه حقيقة فإن دخلت تحت
قدرته فالعجز عما لا يدخل تحت القدرة ايضا ممتنع فإن قيل إنه معجوز عنه
فليس إلا بطريق التوسع لا غير
وأما حقيقة المعجزة فهى كل ما قصد به
ظهار صدق المتحدى بالنبوة المدعى للرسالة فعلى هذا لا يجوز أن تكذب الرسول
كما إذا قال أنا رسول وآية صدقى أن ينطق الله يدى فلو نطقت يده قائلة إنه
كاذب فيما يدعيه لم يكن ذلك آية على صدقه لكن شرط ذلك أن المكذب مما يقع
فى جنسه خرق العادة كما ذكرناه من المثال وأما إن كان غير خارق للعادة فلا
وذلك كما إذا قال آية صدقى إحياء هذا الميت فأحياه الله وهو ينطق بتكذيبه
فإنه لا يكون ذلك تكذيبا بل الواجب تصديقه من جهة أن الإحياء خارق وكلام
مثل ذلك إذا كان حيا غير خارق بخلاف اليد وبه يتبين ضعف من لم يفرق بين
الصورتين من الأصحاب
ولا يجوز أن تكون صفة قديمة ولا مخلوقة للرسول
ولا عامة الوقوع بحيث يستوى فيها البر والفاجر ولا أن تكون متقدمة على
دعواه بأنى رسول وآيتى ما ظهر على يدى
سابقا ولا متأخرا عنها الا
أن تكون واقعة على ما يخبر به عنها بأن يقول آية صدقى ظهور الشئ الفلانى
فى وقت كذا على صفة كذا فإن المعجزة إنما تدل على الصدق من حيث إنها تنزل
منزلة الخطاب بالتصديق وذلك لا يتم عند تحقق هذه الامور كما لا يخفى
بل لا بد وأن تكون خارقة للعادة مقترنه بالتحدى غير مكذبة له ولا متقدمة
عليه و لا متأخرة عنه إلا كما حققناه ولا يشكك فى منع تقدم المعجزة على
التحدى أن يقول آية صدقى أن فى هذا الصندوق المغلق كذا على كذا مع سبق
علمنا بخلوه عما اخبر به فانه إذا ظهر وإن جاز أن يكون مخلوقا لله قبل
التحدى فليس الإعجاز فى وجوده وإنما هو فى إخباره بالغيب
وإذا عرفت
ما حققناه من المعجزة ووجود شرائطها فما سواها من الأفعال إن لم يكن خارقا
للعادة فلا إشكال وإن كان خارقا للعادة فإما أن يكون ذلك على يدى نبى أو
غير نبى فإن كان نبيا فلا إشكال أيضا وإن كان غير نبى بأن يكون وليا أو
ساحرا أو كاهنا أو غير ذلك فد اختلفت أجوبة المتكلمين ههنا
فذهبت
المعتزلة وبعض الأصحاب إلى منع جواز ذلك على يدى من ليس بنبى وقالوا لو
جاز ظهور مثل ذلك على يدى من ليس بنبى أفضى ذلك إلى تكذيب النبى وافترائه
وألا نعرف النبى من غيره ولجوزنا فى وقتنا هذا وقوع ما جرى على أيدى
الانبياء من قبلنا وذلك يوجب لنا التشكك الأن فى كون البحر منفلقا وانقلاب
الموتى أحياء وذلك مما لا يستريب فى إبطاله عاقل
وأما أهل
التحقيق فلم يمنعوا من جواز إجراء مثل ذلك على يدى من ليس بنبى لكن منهم
من قال إن ذلك لا يقع إلا من غير إيثار واختيار بخلاف المجزة وذلك كله مما
لا نرتضيه فإنه ما من أمر يقدر من الأفعال الخارقة وغير الخارقة إلا وهو
مقدور لله تعالى أن يظهره على يدى من شاء من عباده على حسب إيثارة
واختيارة وإنكار ذلك يجر إلى التعجيز وإبطال كون الفعل مقدور لله تعالى
وهو مستحيل
ثم كيف ينكر وقوع مثل ذلك مع اشتهار ما جرى من قصة أصحاب
الكهف وأمى ! موسى وعيسى وما تم لهما من الآيات الغريبة والأمور العجيبة
التى لم تجر العادة بمثلها ولم يكونوا أنبياء إجماعا بل وما جرى للسحرة في
أيام جرجيس وموسى عليهما السلام وليس ذلك مما يفضى إلى تكذيب النبى إذ ليس
شرط المعجزة إلا يؤتى بمثلها وإلا لما جاز أن يأتى النبى بما أتى به الأول
وهو خلاف المذهبين بل شرطها أن تقع موقع التصديق له فيما يدعيه كما سلف
وما ذكروه من تجويز انخراق العادات فى زمننا فهو إنما يستحيل بالنظر إلى
العادات لا بالنظر إلى العقليات كما سبق تحقيقه فإذا الفرق المرضى ليس إلا
فى أن المعجزة واقعة على وفق الدعوى دون غيرها من الأفعال ولا افتراق
بينهما فى الجواز العقلى او فى غير ذلك
لم يبق إلا قولهم إن
الاضلال على الله تعالى جائز وإظهار المعجزة على يد الكاذب جائز أيضا وذلك
أيضا موضع إشكال وقد أجاب عنه بعض الأصحاب فقال لو توقف العلم بتصديقه على
العلم بكون المصدق له غير قاصد للإغواء وعلى كونه غير كاذب لوجب أن من حضر
مجلس الملك وقد قام فيه واحد من عرض الناس فادعى الرسالة ووقعت المعجزة له
من الملك على النحو المفروض ألا يحصل له العلم بصدقه مع قطع النظر عن كون
الملك غير قاصد للإغواء وذلك مخالف للضرورة ومكابر للبديهة وفيه نظر
فإذا السبيل فى الانفصال عن هذا الخيال أن يقال قد بينا أن إظهار المعجزة
على يده فى مقرن دعواه وحصولها على وفق مقالته ينزل منزلة التصديق بالقول
إنك صادق فيما تقول فلو كان الرسول كاذبا لكان المصدق له كاذبا وقد بينا
استحالة ذلك فى حق الله تعالى فهذا مع تقرير القول بأن مقصوده إنما هو
الإغواء وإلقاء الناس فى المضال والأهواء جمع بين النقيضين وذلك أنه إذا
ثبت استحالة الكذب فى حق الله تعالى وأن إظهار المعجزة على يده دليل على
تصديقه فى رسالته استحال كونه كاذبا مما لا معنى له إلا أنه رسول والجمع
بين كونه كاذبا أى ليس برسول وبين ما يدل على انه رسول مستحيل قطعا
وبهذا يتبين ضعف قول بعض الأصحاب بجواز ظهور المعجزة على يد
الكذاب بل لو
قدر كذب من ظهرت المعجزة على يده من غير ما دلت المعجزة منه على صدقه لقد
كان ذلك بالنظر إلى العقل جائزا ولما كان وقوعه بالنظر إليه ممتنعا
وعند هذا فلا بد من التنيبه لدقيقة شدت عن مطولات الكتب وجهابذة المتكلمين
وهى أنه لو قال النبى آية صدقى ظهور جمل او ناقة فى هذا الصندوق أو هذه
الصخرة وذكر من نعته وصفته مع سبق علمنا بعدم ذلك ثم ظهر على وفق قوله
ودعواه فعلى قولنا بجواز ظهور الخارق على يد من ليس بنبى يجوز ان يكون قد
أوتى بمخبر خبره قبل التحدى وعند ذلك فالخارق إنما هو علمه بذلك واطلاعه
عليه لا نفس خبره عند التحدى وبعد العلم به فإن ذلك ليس بمعجز وإلا كان كل
من أخبر عن ذلك بعد ما حصل له العلم به أن يكون خبره معجزا وهو هوس
وإذا لم يكن الخارق المعجز إلا ما قضى بجواز سبقه على التحدى فقد سبق إلى
فهم بعض المجوزين لذلك القاصرين عن الإحاطة بقواعد خواص المتكلمين أن ذلك
لا يكون آية ولا دليلا على الصدق ولا يعلم أن ذلك يجر إلى إبطال اعجاز
القرآن وجعله دليلا 129أ مصدقا لتحقق هذا المعنى فيه بل ويلزم منه ابطال
سائر المعجزات لجواز أن يكون قد أعلم الله ذلك الشخص بأنه سيشق البحر فى
وقت كذا وسيقلب العصا حية إلى غير ذلك وأنى يكون ذلك والله تعالى بما منحه
من هذا لاطلاع الخارق والإحاطة بالمعجزة مع عمله بأنه سيتحدى ويستند فى
الاستدلال والإعجاز إلى ما أظفره به ينزل منزلة التصديق له بالقول وإن
تأخرت معرفة ذلك إلى حين وهل بين ذلك وبين ما لو كان حصوله مقارنا للدعوى
فرق فى هذا المعنى
نعم شرط ذلك ألا يكون هذا الخارق قبل التحدى قد ظهر للناس منه واشتهر عنه
فإن إظهاره لهم عند دعوته لا ينزل فى نظر العقلاء منزلة التصديق
وهذا
بخلافه إذ لم يكن ظهوره لهم على يده إلا مقارنا لدعوته ومن نظر فيما
قررناه بالتحقيق اندفع عنه خيال اشتراط عدم سبق المعجزة مطلقا فى تنزيله
منزلة التصديق
وما أشير اليه من إلزام إفحام الرسل فإنما يلزم أن لو
قيل بوجوب الإمهال فى النظر والاعتبار بالعبر وهو إنما يلزم المعتزلة حيث
اعترفوا بوجوب الامهال عند الاستمهال ولا محيص لهم عنه فأما على رأى أهل
الحق فلا وأنى يجب ذلك على من ظهر صدقه فى مقالته بالدلالات الواضحة
والمعجزات الائحة لا سيما وهو متصد للدعوة الشامخة والكلمة الباذخة وما
فيها من صلاح نظام الخلق والإرشاد إلى السبيل الحق الذى به يكون معاشهم فى
الدنيا وحصول سعادتهم فى الأخرى وإنما ذلك مبنى على فاسد أصول الخصوم فى
التحسين والتقبيح وقد أبطلناه بل ولو وقع الإلزام على أصلهم بقبح التأخر
والإمهال فى النظر حيث لم يرشدهم إلى المصالح ويحذرهم من المهالك ويعرفهم
طريق السعادة ليسلكوها ومفاوز المخافة ليرهبوها بعد ما ظهر صدقه واتضحت
كلمته بالمعجزات القاطعة والبراهين الساطعة لم يجدوا إلى دفع ذلك سبيلا
كيف وأن ما يجب النظر لأجله فالنبى قائم بصدده ومتكفل بأوده من تعريف ذات
البارى وصفاته وما يتعلق بأحكام الدنيا والأخرى ولهذا إذا فحص عن أحوال
الأنبياء والمرسلين وجدناهم فى الدعوة إلى الله تعالى و إلى معرفة
وحدانيته سابقين ولذلك على دعوى النبوة مقدمين
وعند ذلك فليس طلب
الإمهال مع ما ظهر من صدق الرسول ودعوته إلى ما فيه صلاح نظام المدعو مع
إمكان وقوع الهلكة على تقدير التأخر إلا كما لو قال الوالد لولده مع ما
عرف من شفقته وحنوه ورأفته إن بين يديك فى هذا الطريق سبعا
أو
مهلكة وإياك وسلوكه وكان ذلك فى نفسه ممكنا فقال الولد لا أمتنع من ذلك ما
لم أعرف السبع أو المهلكة لقد كان ذلك مه فى نظر أهل المعرفة يعد مستقبحا
ومخالفا للواجب ولو لم ينته فهلك كان ملوما مذموما غير معذور
وأما
ما ذكروه من قبح البعثة إلى من علم الله أنه لا يؤمن فهو أيضا مبنى على
أصلهم فى التلكيف لما لا يطاق والقبح والحسن وقد أفسدناه
ثم يلزم
الصابئة الملتزمين لتصديق شيث وإدريس ومن التزم من البراهمة بتصديق آدم
وابراهيم المنع من إحالة تصديق غيرهم من المرسلين فإنه مهما وجد دليل يدل
على صدق بعض المخبرين بطريق اليقين لم يمتنع وجود مثل ذلك فى حق غيره أيضا
وما انفردت به التناسخية فهو فرع أصلهم فى التناسخ وقد أبطلناه وعند
ذلك فلا بد من معرف يعرف بالطرق الجيدة والأحوال السديدة التى يتعلق بها
صلاح الخلق فى مآلهم فإن ذلك مما لا يعرف العقل إذ الافعال مما لا تقبح
ولا تحسن لذواتها حتى يسبق العقل بدرك الصالح والفاسد منها بل لعل العقل
قد يقبح مع النفس بغض الأفعال التى تحصل بها الملاذ وتتعلق بها الأغراض
إذا قطع النظر عما يتعلق بها من الملاذ
ثم العبد إذا انتهى إلى
العالم العلوى أو السفلى جزاء على فعله فما يفعله فى حالة خسته او في حالة
رفعته مما يوجب اقتضاء زيادة فى حاله يبقى مما لا مقابل له لانتهائه فى
درجة الثواب إلى ما لا درجة للثواب بعدها وكذلك فى درجة العقاب أيضا وهو
مما يفضى إلى
تعطيل طاعة من هو فى الدرجة العليا عن الثواب
ومعصية من هو فى الدرجة السفلى عن العقاب وهو مما يقبح على موجب
اعتقاداتهم ولا محيص عنه
ولا يتخيلن أن إنكار الرسالة مما يستدعى
الإقرار بها من جهة الخبر عن الله تعالى بأن لا إرسال ولا رسول كما ظن بعض
الأصحاب إذ الخير بذلك ونفيه إنما يستند عندهم إلى الدليل العقلى لا إلى
التوقيف السمعى وذلك لا يلزم منه الاعتراف بالرسالة أصلا إلى غير ذلك من
قضايا العقول
فإذا قد تنخل من مجموع ما ذكرناه عند النظر اللبيب
والفهم الأريب جواز الارسال وامتناع لزوم المحال وسيتضح ذلك زيادة إيضاح
ببيان وقوعها بالفعل إن شاء الله تعالى
2 -
الطرف الثانى
فى بيان وقوعها بالفعل واثبات معرفتها بالنقلومن ثبتت نبوته واشتهرت رسالته بالمعجزات والدلالات القطعيات أكثر من أن يحصى ولنقتصر من ذلك على إثبات نبوة سيد الأولين والآخرين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله اجمعين إذ الطوائف على إنكار بعثته متفقون وفى مآخذهم مختلفون
فرب من أنكر رسالته بمجرد القدح في معجزاته والطعن فى آياته كالنصارى وغيرهم من المعترفين بجواز نسخ الشرائع وبعثة الرسل
ورب من أنكر رسالته لاعتقاده إحالة نسخ الشرائع وتبدل الذرائع كبعض اليهود لكن منهم من أحال ذلك عقلا كالشمعنية ومنهم من أحاله سمعا كالعنانية ولم يوافق أهل الإسلام على كونه نبيا غير العيسوية فإنهم معترفون برسالته لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة
والذى يدل على صحة رسالته وصدقه فى دعوته ما ظهر على يده من المعجزات والآيات الباهرات
فمن جملتها القرآن المجيد الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا
من خلفه
تنزيل من حكيم حميد فإن من نظر بعين الاعتبار وله قدم راسخ فى الاختبار
اعلم أن القرآن من أظهر المعجزات وأبلغ ما تخرق به العادات وأن ذلك مما لا
يدخل تحت طوق البشر ولا يمكن تحصيله بفكر ولا نظر لما اشتمل من النظم
الغريب والأسلوب المخالف لما استنبطه البلغاء من الاوزان والأساليب مع
الجزالة والبلاغة وجمع الكثير من المعانى السديدة في الألفاظ الوجيزة
الرشيقة وإليه الاشارة بقوله عليه السلام أوتيت جوامع الكلم واختصرت لى
الحكمة اختصارا وذلك كما دل على وحدانيته وعظم صمديته والإرشاد لمن ضل إلى
معرفته بقوله يسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض فى الأكل فانه بينة على
أن ذلك كله ليس إلا بمشيئته وإرادته وأنه مقدور بقدرته وإلا فلو كان ذلك
بالماء والتراب والفاعل له الطبيعة لما وقع الاختلاف
ومما كثرت
معانيه وقل لفظه على أتم بلاغة وأحسن فصاحة قوله تعالى خذ العفو وأمر
بالعرف وأعرض عن الجهلين فإنه مع قلة ألفاظه ورطوبتها قد دل على العفو عن
المذنبين وصلة القاطعين وإعطاء المانعين وتقوى الله وصلة الأرحام وحبس
اللسان وغض الطرف وغير ذلك من المعانى
ومن أراد زيادة الاختبار فعليه بالاعتبار والنظر فى مجمله ومفصله ومحكمه
ومتشابهه
فإنه يجد فى طى ذلك العجب العجاب ويحقق بما أمكنه من إدراكه
إعجازه لذوى
العقول والألباب وان أبلغ وأحسن ما نطقت به بلغاء العرب من ذوى الأحساب
والرتب المختصين من بين الأمم المميزين عن سائر أصناف العجم بما منحهم
الله تعال به من اللسان العربى المبين إذا نسبه إلى الكلام الربانى واللفظ
اللاهوتى وجد النسبة بينهما على نحو ما بين اللسان العربى والأعجمى ولعلم
من نفسه ما اشتمل عليه من الإعجاز والبلاغة والايجاز وإن ذلك مما تتقاصر
عن الاتيان بمثله أرباب اللسان وتكل عن معارضته الانس والجان قل لئن
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله ولو كان
بعضهم لبعض ظهيرا
فإنك ألا ترى إلى فصيح قول العرب فى معنى ارتداع
سافك الدم بالقتل القتل أنفى للقتل وفى قوله تعالى فى القصاص حياة وما
بينهما من الفرق فى الجزالة والبلاغة والتفاوت فى الحروف الدالة على
المعنى ومن كان أشد تدربا ومعرفة بأوزان العرب ومذاهبها فى اللغات
وأساليبها في العبارات كان أشد معرفة بإعجاز القرآن وأسبق إلى التصديق
والإيمان كما أن من كانت معرفته بعلم الطبيعة فى زمن إبراهيم وعلم السحر
فى زمن موسى والطب فى زمن عيسى أشد كان أشد معرفة بالإعجاز وأسبق للتصديق
والقبول لما جاء به الرسول
كيف والعرب مع شدة بأسها وعظم مراسها
ومنعتهم عن أن يدخلوا فى حكم حاكم ونبوتهم عن أن يقبلوا رسم راسم منهم من
أجاب بالقبول وأذعن بالدخول ومنهم من نكل عن الجواب واعتضد بالقبائل
والأصحاب ولم يرض غير القيل والقال والحرب والنزال فاستنزل بالعنف عن
رتبته وأخذ بالقهر مع نبوته فلو أن ذلك مما لهم سبيل إلى
معارضته
أو إبداء سورة فى مقابلته مع أنهم أهل اللسان وفصحاء الزمان لقد كانوا
يبالغون فى ذلك ما يجدون إليه سبيلا لإفحام من يدعى كونه نبيا أو رسولا إذ
هو أقرب بالطرق إلى إفحامه وأبلغها فى دحره وانحسامه وادراء لما ينالهم فى
طاعته ومخالفته من الأوصاب وكفا لما يلحقهم فى ذلك من الأنصاب وخراب
البلاد ونهب الأموال واسترقاق الأولاد
لا سيما وقد تحدى بذلك تحدى
التعجيز عن الاتيان بمثله فقال فأتوا بكتاب مثله بل بعشر سور من مثله بل
سورة واحدة فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا إلا أن منهم من وقف على معجزته وعرف
وجه دلالته فواحد لم يسعه إلا الدخول فى الإيمان والمبادرة إلى الاذعان
وواحد غلبت عليه الشقاوة واستحكمت منه الطغاوة فخذل بذنبه ونكص على عقبه
وقال أبشرا منا واحدا نتبعه إن هذا إلا سحر مبين
ومنهم من حمله فرط
جهله وقصور عقله على المعارضة والإتيات بمثله كما نقل من ترهات مسيلمة فى
قوله الفيل والفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل وخرطوم وثيل وقوله
والزارعات زراعا فالحاصدات حصدا والطاحنات طحنا إلى غير ذلك من كلامه ولا
يخفى ما فى ذلك من الركاكة والفهاهة وما فيه من الدلالة على جهل قائله
وضعف عقله وسخف رأيه حيث ظن أن هذا الكلام الغث الرث الذى هو مضحكة
العقلاء ومستهزأ الأدباء معارض لما أعجزت الفصحاء معارضته واعيه الألباء
مناقضته من حين البعثة إلى زماننا هذا
بل لو نقر العاقل على ما
فيه من الإخبار بقصص الماضين وأحوال الأولين على نحو ما وردت به الكتب
السالفة والتواريخ الماضية مع ما عرف من حال النبى صلى الله عليه و سلم من
الأمية وعدم الاشتغال بالعلوم والدراسات بل وما فيه من الإخبار عما تحقق
بعد ما أخبر به من الغائبات كما فى قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن
على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
وقوله لتدخلن المسجد الحرام وقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وقوله
آلم غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لقد كان ذلك كافيا
له فى معرفة إعجاز القرآن وصادا له عن المكابرة والبهتان
ومن جملة
آياته ومعجزاته الظاهرة حنين الجذع اليابس إليه وسلام الغزالة عليه وكلام
الذراع المسموم له وتسبيح الحصى فى يده ولا محالة أن هذه كلها من الخوارق
للعادات وليست مما يدخل تحت وسع شئ من المخلوقات وانه نبى لا ينطق عن
الهوى إن هو إلا وحى يوحى
وللخصوم على ما ذكرناه أسئلة
السؤال الأول
أنهم قالوا ما ذكرتموه من كون القرآن معجزا لا بد من أن تثبتوا بطريق قطعى
يقينى أنه مما ظهر على يده واقترن بدعوته اقتران التصديق والا فلا نأمن أن
ذلك من خلق الأولين أو تخرصات المتأخرين
ثم إن ذلك ولو كان مسلما
فلا بد أن تبينوا وجه الإعجاز فيه وذلك يتعذر من جهة أن القرآن قد يطلق
بمعنى المقروء وقد يطلق بمعنى القراءة فإن كان المقروء هو المعجز فذلك
عندكم صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى والصفة القديمة يستحيل أن تكون
معجزا إذ لا اختصاص لها بحادث دون حادث وإن كان المعجز هو القراءة التى هى
فعله وكسبه فليست معجزة فانها لا تنزل منزلة التصديق له فيما يقوله كما
سلف
وأما ما ذكرتموه من وجه إعجازه فى النظم والبلاغة والفصاحة
فأنتم فى ذلك مختلفون فقائل إن المعجز هو النظم دون الفصاحة وقائل الفصاحة
دون النظم وقائل إن المعجز فيه صرف الدواعى عن الإتيان بمثله وقائل إن
المعجز فيه هو المجموع وهذا الاختلاف مما يوجب خفاء الاعجاز فيه والمعجز
يجب أن يكون وجه إعجازه ظاهرا بالنسبة إلى جل من هو معجزة بالنظر إليه
ودليل عليه ظهورا لا يكون فيه شك ولا ريبة
وما ذكرتموه من عجز بلغاء العرب عن مقابلته وكلالهم عن معارضته فإنما
يتحقق
أن لو ثبت أنه تحدى عليهم به ومنعهم من الإتيان بمثله وذلك غير
معلوم فلا
بد من إثباته ثم ولو ثبت أنه تحداهم به فما الذى يؤمننا من أن المعارضة
وقعت واتفقت الأهواء على دفعها وإبطالها أو صرف الله دواعى الخلق عن نقلها
وأنساهم إياها أو أن خوف السيف منعهم من إظهارها أو أنهم لم يتعرضوا
بالمعارضة لإعراضهم عن النظر فى أن ذلك مما يوجب إفحامه وإبطال دعوته أو
أن إعراضهم كان قصدا لإهانته وإخماله بترك معارضته أو لاعتقادهم أن السيف
والسنان أقرب إلى إخماد ثائرته وإطفاء جمرته من الاتيان بمعارضته والتطويل
فى محاورته وإلا فكيف يعجزون عن الاتيان بمثله وهو غير خارج عن حروف
المعجم التى يتكلم بها العرب والعجم والأمكن والألسن
كيف وإنه ما من
أحد إلا وهو قادر على أن يأتى منه بالكلمة والكلمات والآية والآيات ومن
كان قادرا على ذلك كان قادرا على كله لكن غاية ما يقدر أنه يتميز عليهم
بنوع فصاحة وجزالة وذلك غير مستحيل إذ التفاوت فيما بين الناس في ذلك واقع
لا محالة وليس له حد يوقف عنده إذ ما من فصيح إلا ولعل ثم من هو أفصح منه
فغير ممتنع أن تنتهى الفصاحة فى حق شخص إلى حد يعجز عن الإتيان بمثله وذلك
لا يوجب جعله نبيا وإلا للزم أن من كان دونه فى الدرجة أن يكون نبيا
وكلامه معجزا بالنسبة إلى من هو دونه وأن يكون هو متبوعا بالنسبة إلى من
هو دونه وتابعا بالنسبة إلى من هو أفصح منه
ثم إنه يمتنع أن يكون
معجزا من وجهين الوجه الأول أنه من الجائز أن يكون ذلك قد حصل له قبل
التحدى بالنبوة وادعاء الرسالة ولم يظهر عليه فإنه لا مانع على أصلكم من
إجراء الخوارق على يد من ليس بنبى وعلى تقدير جواز تقدمه على التحدى يخرج
عن أن يكون دالا على صدقه من حيث إن المعجزة لم تدل إلا من جهة أنها نازلة
منزلة التصديق بالقول وذلك لا يكون إلا مع وجودها عند الدعوى لا قبلها كما
سبق وليس إظهار ذلك عند الدعوى خارقا كما فى الإحياء وشق البحر ونحوه بل
هو محض تلاوة وتكرار ولا افتراق فيه بين إنسان وإنسان وإنما الخارق إظهاره
إليه وإطلاعه عليه ومع جواز سبقه يمتنع أن يكون دالا على صدقه
والوجه الثانى أن من حفظه ومضى به إلى أهل بلد لم تبلغهم الدعوة ولم
يسمعوا بمثله ولا بمن ورد على يده فتحدى به عليهم فلا بد من أن يوجب
التصديق أو التكذيب فإن أوجب التصديق فهو معلوم كذبه وأن أوجب التكذيب مع
ما ظهر لهم على يده من الخارق أفضى إلى إفحام الرسل وإبطال المجزات وظهور
الآيات ولذلك لا سبيل إلى القول بمثل ما ينقل ويحفظ أن يكون معجزا دالا
على صدق الرسالة بل المعجزات يجب ان تكون كشق البحر وإحياء الموتى وقلب
العصا حية إلى غير ذلك مما لا سبيل إلى ظهوره على يد غير نبى
فإذا
قد ثبت انه لا إعجاز في القرآن ثم ولو كان معجزا بناء على كونه خارقا لوجب
أن يكون ما ظهر من العلوم الرياضية كالهندسية والحسابية معجزا وأن يجب
التصديق لمن أتى به عند تحديه بالرسالة ودعواه للنبوة وهو محال
وما ذكرتموه من تسبيح الحصى وانشقاق القمر وتكليم الغزالة وحنين
الجذع
ونحو ذلك فآحاد هذه الامور غير معلومة ولا منقولة بطريق التواتر وإنما هى
مستندة إلى الآحاد وهى مما لا سبيل إلى التمسك بها فى القطعيات و إثبات
النبوات
وزادت العنانية على هؤلاء فقالوا قد ثبت أن موسى الكليم كان
نبيا صادقا بما ظهر على يده من شق البحر وقلب العصا حية وبياض يده إلى غير
ذلك وقد نقل عنه بالتواتر خلق عن سلف أنه قال لقومه هذه الشريعة مؤبدة
عليكم لازمة لكم ما دامت السموات والأرض فقد كذب كل من أدعى نسخ شريعته
وتبديل ملته فلو قلنا إن محمدا كان نبيا وإن شرعه ناسخ بطريق الصدق للزم
أن يكون موسى الكليم فيما قاله كاذبا وهو محال
وزادت الشمعنية على
العنانية بأن قالوا لو جاز أن يكون محمد نبيا لجاز القول بنسخ الشرائع
والنسخ فى نفسه محال فإنه اذا أمر بشئ فذلك يدل على حسنه وكونه مرادا وأن
فيه مصلحة فلو نهى عنه انقلب الحسن قبيحا والمصلحة مفسدة وما كان مرادا
غير مراد ويلزم من ذلك البداء والندم بعد الأمر والطلب وهو ممتنع فى حق
الله تعالى ثم إن مدلول النسخ فى الوضع ليس إلا الرفع وذلك لا سبيل إلى
تحققه فيما أمر به ونهى عنه فإنه أما أن يكون الرفع لما وقع أو لما لم يقع
فإن كان لما وقع فهو محال وإن كان لما لم يقع فرفع غير الواقع محال أيضا
كما وقع فى الواقع
وأما العيسوية منهم فإنهم قالوا سلمنا ظهور
المعجزات على يده واقترانها بدعوته لكنه إنما ادعى الرسالة للعرب خاصة لا
إلى الأمم كافة فلا بد لبيان عموم دعواه من دليل قاطع ولا سبيل إليه
والجواب عن كلمات أهل الزيغ عن الصواب
أما إنكار ظهور القرآن على يده واقترانه بدعوته فمما لا سبيل إليه إلا فى
حق من رفع نقاب الحياء عن وجهه وارتكب جحد الضرورة الحاصلة من أخبار
التواتر بذلك فإن ما من عصر من الأعصار ولا قطر من الأقطار إلا والناس فيه
بأسرهم مطبقون الموافقون والمخالفون على أن ذلك مما لم يظهر إلا على يده
ولا صدر إلا من جهته واستقر ذلك فى الأنفس على نحو استقرار العلم بالملوك
الماضية والأمم السالفة والبلاد النائية فمن تفوه بإنكاره فقد ظهرت مخازيه
وسقطت مكالمته وكان كمن أنكر وجود مكة وبغداد ووجود من اشتهر من هؤلاء
العباد ونحو ذلك وبه يندفع تشكيك من شكك على نفى العلم الحاصل بالأخبار
الواردة على لسان الجمع الكثير والجم الغفير بأن ما من واحد إلا والكذب فى
حقه ممكن وحصول العلم بخبره ممتنع وذلك لا ينتفى عنه بسبب انظمامه إلى من
هو مثله فى الرتبة ولا حاجة إلى الإطناب
وأما جواز الإعجاز من جهة القراءة والمقروء فتهويل لا حاصل له فإنا لا
نقول
إن المعجز هو الصفة القديمة القائمة بذات الرب تعالى ولا ما
يتعلق من القراءة بكسب القارئ بل وجه الإعجاز فيه قد يتقرر من وجهين
فتارة نقول إن المعجز هو إظهار ذلك المقروء القائم بالنفس على لسان الرسول
بما خلق الله من العبارات الدالة عليه فلا يكون كلامه الدال هو المعجز ولا
المدلول بل إظهار ذلك المدلول بكلامه عند تحديه بنبوته ولا محالة أن ذلك
مما يتقاصر عن تحصيله أرباب الفكر ويكل دونه حذاق أهل النظر وذلك كما
ذكرناه فى قضية المتحدى باظهار ما فى الصندوق ونحوه
وتارة نقول إن
المعجز هو هذه العبارات وهذه الكلمات من جهة ما اشتملت عليه من الفصاحة
والبلاغة والنظم المخصوص وذلك مما لا يدخل تحت قدرة النبى ولا هو متوقف
على إرادته بل هو مقدور ومخلوق لله تعالى وما هو مقدور له ومتعلق كسبه
فليس إلا حفظه وتلاوته ونسبته إليه كنسبته إلينا فإنا نعلم من أنفسنا عند
قراءته والشروع فى تلاوته أن ما هو متعلق كسبنا منه ليس إلا القراءة
والتلاوة دون النظم والبلاغة وما اشتمل عليه من الفصاحة لكن لما اختص
بإظهار ذلك على لسانه بطريق الوحى عن ربه مقارنا لدعوته وكان ممن تكل عن
الإتيان بمثله قوى البشر ويعجز عن معارضته ذوو القدر كان ذلك دليلا على
صدقه كما سلف
ومن صفت فطرته واشتدت قريحته وكان ناظرا أريبا علم أن
ما من آية من القرآن إلا وهى لما اشتملت عليه من النظم البديع والترتيب
البليغ والمعنى معجزة وأنه من عند رب العالمين وعلى قدر سلامة الفطر وصحة
النظر يقع التفاوت
بين الناظرين فى إعجاز القرآن العظيم فرب شخص
يكون عنده بالنظر إلى نظمه وحده معجزة و بالنظر إلى بلاغته معجزة ورب شخص
يكون الإعجاز عنده من الأمرين وعلى هذا التفاوت يكون الاختلاف بين الآية
والسورة والكتاب برمته فى الاعجاز فالخفاء إن وقع فى إعجازه بالنسبة إلى
نظمه أو بلاغته أو بالنظر إلى آيه وسوره فلا خفاء بأن مجموع ذلك يكون
خارقا معجزا ولا اختلاف فيه عند القائلين به
وأما إنكار تحديه
بالقرآن للعرب وإفحامه ذوى الأدب فهو أيضا مما علم بالضرورة والنقل
المتواتر كما علم وجوده وظهور القرآن على يده ولا حجة لإنكاره كيف والقرآن
مشحون بقوارع من الآيات دالة على التحدى ونعى العرب مثل قوله فأتوا بكتاب
من عند الله فأتوا بعشر سور فأتوا بسورة من مثله وقوله لئن اجتمعت الإنس
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله إلى غير ذلك من الآيات
فكيف يقال بإنكار وقوع التحدى
ثم ما من آية من هذه الآيات الا وهى
منقولة على لسان التواتر وهو سواء فى سائر الآيات وذلك مما يمتنع معه
القول بكونها مؤلفة بعد النبى عليه السلام أو أنها مجمعة لغيره من الأنام
فإذا ثبت تحديه به العرب وأرباب الفضل منهم والأدب فلو وقعت المعارضة منهم
لاشتهر ذلك ولتوفرت الدواعى على نقله كما توفرت على نقل غيره إما على لسان
الموافق أو المخالف إذ السكوت عن مثل هذا والتواطؤ على تركه مما تقضى
العادة الجارية
بإحالته والمدعى لذلك ليس هو فى ضرب المثال إلا
كمن يدعى ظهور نبى آخر بعد النبى عليه السلام أو وجود إمام قبل الأئمة
الأربعة أو أن البحر نشف فى بعض الأوقات أو الدجلة او الفرات ولا يخفى ما
فى ذلك من الإبطال
ولا يمكن أن يكون خوف السيف مانع من نقل ذلك
وإظهاره فى العادة كما لم يمنع دعوى المعارضة فى كل زمان وإن كان ذلك لما
فى القرآن بل الواجب بالنظر إلى العادات ومقتضى الطباع النقل لمثل ما هو
من هذا القبيل ولو على سبيل الإسرار كما قد جرت به عادة الناس في التحدث
بمساوئ ملوكهم وإظهار معايبهم وإن كان خوف السيف قائما فى حقهم لا سيما
وبلاد الكفار متسعة وكلمة الكفر فى غير موضع شائعة فلو كان ذلك مما له
وقوع قد أشيع كما أشيع غيره مما ليس بموافق للدين ولا يتقبله أحد من
المسلمين
ولا جائز أن يقال إن ترك المعارضة محمول على الإهمال أو
على الغفلة عن كون المعارضة موجبة للإفحام أو على اعتقاد ان السيف أبلغ فى
دحره وردعه وإبطال جعوته فإن النبى صلى الله عليه و سلم قد كان يقرعهم
بالعى ويردد عليهم تعجيزهم فى الأحياء ويقول قأتوا بسورة مثله وادعوا من
استطعتم من دون الله مع أن العرب قد كانت فى محافلها تتفاخر بمعارضة
الركيك من الشعر وتتناظر فى مجالسها بمقابلة السخيف من النثر ولا محالة أن
القرآن فى نظر من له أدنى ذوق من العربية وأقل نصاب من الأمور الأدبية لا
يتقاصر عن فصيح أقوال العرب وبديع فصولهم فى النظم
والنثر بل
والخطب فكيف يخطر بعقل عاقل أو يتوهم واهم أن العرب مع ما أتوه من العقل
الغزير ومن حسن التصرف والتدبير تتاركوا معارضة القرآن إخساسا به وإهمالا
أو لغفلتهم أن ذلك مما يدفع الضرر عنهم او لأن السيف أنجع واوقع لهم مع ما
كان المسلمون عليه من شدة البأس وعظم المراس والقوة الباهرة والعزمة
الحاضرة والنصرة الحاصرة وهم يمكنهم دفع ذلك كله بفصل أو سورة يقولها واحد
منهم إن هذا لهو الخسران المبين
ولا ننكر أن هذه المثلات ووقوع هذه
الاحتمالات بالنظر إلى العقل و إلى ذواتها ممكنات لكنها كما اوضحناه
بالنظر إلى العادة من المستحيلات ولا يلزم أن ما كان ممكنا باعتبار ذاته
أن لا يلزم المحال من فرض وجوده أو عدمه باعتبار غيره كما حققناه فى غير
موضع من هذا الكتاب ثم إن هذه الاحتمالات إن كان الخصم كتابيا فهى أيضا
لازمة له فى إثبات نبوة من انتمى إليه والقول بتصحيح رسالة من اعتمد عليه
وذلك كالنصارى واليهود وغيرهم من أهل الجحود فما هو اعتذاره عنها هو
اعتذارنا عنها ههنا
ولا يلزم من كون القرآن مركبا من الحروف
والأصوات أن لا يكون خارقا ولا معجزا لما بيناه من اشتماله على النظم
البديع والكلام البليغ الذى عجزت عنه بلغاء العرب وفصحاؤهم وقدرة بعض
الناس على الإتيان بما شابه منه كلمة أو كلمات لا توجب القدرة على ما وقع
به الإعجاز وإلا كان لكل من أمكنه الإتيان
بكلمة أو كلمتين من
نظم أو نثر أن يكون شاعرا ناثرا وأو لا يقع الفرق بين الألكن والألسن ولا
يخفى ما فى ذلك من العبث والزلل فإنا نحس من أنفسنا العجز عن بعض ما نقل
عن فصحاء العرب من نظم أو نثر وإن كنا لا نجد أنفسنا وقدرنا قاصرة عن
الإتيان منه بكلمة او كلمات بل وليس هذا إلا نظير ما لو قيل بوجوب كون
الجبل مقدورا حمله بالنسبة إلينا لكون بعضه مقدورا إذ هو زيف وسفسطة ثم
ولو كان ذلك مقدورا لهم لقد بادروا إلى الإتيان به وسارعوا إلى دفع ما
تحدى به على ما سلف
لكن لا ننكر أن من مقدورات الله تعالى أن يظهر
على يد غيره ما يعجز عن الإتيان بمثله وتكون نسبته إلى هذا المعجز كنسبة
هذا المعجز إلى غيره من الكلام وأن ذلك لو ظهر لكان مبطلا لرسالته أن لو
كان التحدى بأنه لا سبيل إلى الإتيان بمثله لا أن يكون التحدى بإظهار ما
هو خارق للعادة على يده فقط أى لم يعهد له فى العادة قبل ذلك مثال كما سبق
تحقيقه وكذا الكلام فيما هو دونه بالنسبة إليه أيضا
وأما منع جواز دلالته على الصدق بناء على جواز تقدمه على الدعوى فقد سبق
وجه إبطاله فيما مضى فلا حاجة إلى إعادته
وأما ما فرض من جواز تحدى من حفظه على أهل بلد لم تبلغهم الدعوة فمجرد
ظهوره على يده غير كاف مهما لم يعلم بطريق قطعى أن ذلك مما لم يظهر على يد
غيره وغاية ما فى الباب أنهم لو علموا ظهور ذلك على يد غيره فذلك لا يوجب
العلم بعدم ظهوره على يده هو لكن لعله لو تلاه عليهم لقد علم أنه مما لم
يظهر على يده من جهة اشتماله على شرح أحوال وأمور وأحكام اختصت بأسباب
ووقائع حدثت فى زمن النبى صلى الله عليه و سلم
لو ذكرت بالنسبة
إلى غيره لقد كان في نفسه يعد لغوا من القول وسفها من الكلام ولا كذلك فى
حق النبى عليه السلام فإنه قد علم من جهة القطع أن ذلك مما لم يظهر على يد
غيره بناء على ما احتف به من القرائن القطعية والأمور اليقينية من نزوله
على وفق أحوالهم ومطابقته لأقوالهم وذلك كما قى قصة براءة عائشة وذم أبى
لهب وما ورد من الآيات في يوم بدر وأحد إلى غير ذلك مما يمتنع تصوره عند
كونه كاذبا فى دعواه بل البارى تعالى يطبع على قلبه وعقله ويختم على لسانه
بحيث لا يتمكن من إبيانه والتحدى به أصلا
وأما غيره من الكتب
الغريبة والأمور العجيبة من الرياضيات والهندسيات والحسابيات والأمور التى
لا يمكن الإتيان بمثلها فقد قيل إن مستند إظهارها وسبب اشتهارها ليس إلا
من النبيين والمرسلين وغاية ما زيد فيها تتميم وترتيب ولو قدر أنها مما لم
يظهر على يدى نبى فلا إحالة فى ذلك لما سلف وعند التحدى بها وثبوت كونها
خارقة يجب القول بالتصديق والقبول بالتحقيق لكون ما ظهر على يده نازلا
منزلة التصديق له بخلق الله تعالى له ذلك على يده واقترانه بدعوته كما سبق
ثم إن ذلك لازم للخصم إن كان كتابيا بالنسبة إلى ما ظهر على يد نبيه من
المعجزات والآيات ولا مخلص له منه
وما قيل من آحاد المعجزات التى أشرنا إليها من انشقاق القمر وتسبيح
الحصى ونحوه لم يثبت بطريق متواتر فبعيد فإنا نعلم ضرورة أن ما
من عصر من
الأعصار إلا وأصحاب الأخبار وأرباب الآثار وأهل السير والتواريخ قوم لا
يتصور منهم التواطؤ على الكذب عادة وهم بأسرهم متفقون على نقل آحاد هذه
الأعلام وكذا في كل عصر إلى الصدر الأول
ثم ولو سلم ذلك فى الآحاد
فلا محالة أن عموم ورودها يوجب العلم بصدور المعجزات عنه وظهور الخوارق
عنه جملة كما نعلم بالضرورة شجاعة عنتر وكرم حاتم لكثرة ما رواه النقلة
عنهما من أحوال مختلفة تدل على كرم هذا وشجاعة هذا وإن كان نقل كل حالة
منهما نقل آحاد لا نقل تواتر
وأما الرد على العنانية فيما تقولوه
وإبطالهم فيما تخرصوه فهو أنهم مع عجزهم عن صحة السند فى متن الحديث
مختلفون فإن منهم من قال الحديث هو قوله إن أطعتمونى لما أمرتكم به
ونهيتكم عنه ثبت ملككم كما ثبتت السموات والأرض وليس فى ذلك ما يدل على
دوام الملك فليس ذلك ينافى النسخ ثم هو مشروط بطاعته والائتمار بمأموراته
والإنتهاء عن منهياته وذلك مما لا يتحقق فى حقهم بعده ثم وإن قدر أن
المنقول هو قوله هذه الشريعة لازمة لكم خاتمة عليكم
فلا مانع من أن يكون ذلك مشروطا بعدم ظهور نبى آخر ويكون هو
المراد باللفظ ومع تصور هذا الاحتمال فلا يقين
وأما استبعاد أن يكون الشئ الواحد حسنا قبيحا طاعة معصية مصلحة مفسدة
مرادا غير مراد فقد أشرنا إلى إبطال مستند هذه الأصول ونبهنا على زيف جميع
هذه الفصول من التحسين والتقبيح ورعاية الصلاح والأصلح ودلالة الأمر على
الإرادة بما فيه مقنع وكفاية
ثم إنه لا يبعد صدور الأمر من الله
تعالى نحو المكلفين بفعل شئ مطلقا فى وقت ويكون ذلك ممدودا فى علم الله
إلى حين ما علم أنه ينسخه عنده لعلمه بأن مصلحة المكلف فى ذلك الأمر
لاعتقاده لموجبه وكف نفسه عما يغويه ثم يقطع عنه التكليف فى الوقت الذى
علم أنه سينسخه عنده لعلمه بما فيه من المصلحة وكف المفسدة يمحوا الله ما
يشاء ويثبت ويكون ذلك الفعل نفسه بالإضافة إلى وقت متعلق المصلحة والحسن و
الإرادة و بالإضافة إلى غيره متعلق القبح والمفسدة والكراهة وذلك كما أمر
بالصيام نهارا ونهى عنه ليلا ونحو ذلك
وعلى هذا يندفع ما ذكروه
من البداء والندم فإن ذلك إنما يكون أن لو انكشف له فى ثانى الحال ما أوجب
له المنع عن الفعل والنهى عنه ولم يكن قد حصل ذلك له أولا ومن استعمل من
الأصحاب لفظ الرفع فى النسخ فليس المعنى به غير قطع استمرار ما كان له من
القوة والاستحكام وأن يبقى لولا الناسخ وذلك على وزان قطع حكم عقد البيع
المطلق المستحكم بالنسبة إلى الفسخ وهذا ليس برفع لما وجد ولا لما لم يوجد
ولا معنى للنسخ عند الإطلاق به إلا هذا فقد بطل إذا ما تخيلوه وفسد ما
توهموه
ولا يتوهمن إضافة قطع الاستمرار إلى الكلام الذى هو صفة الرب
الكريم فإن العدم عليه مستحيل بل المراد إنما هو قطع تعلقه بالمكلف وكف
الخطاب عنه وذلك غير مستحيل
وأما العيسوية فيمتنع عليهم بعد التسليم
بصحة رسالته وصدقه فى دعوته إلا الإذعان لكلمته إذ لا سبيل إلى القول
بتخصيص بعثته إلى العرب دون غيرها من الأمم مع ما اشتهر عنه وعلم بالضرورة
والنقل المتواتر من دعوته إلى كلمته طوائف الجبابرة وغيرهم من الاكاسرة
وتنفيذه إلى أقاصى البلاد وملوك العباد وقتال من عانده ونزال من جاحده ثم
ذلك معتمد على سند الصدر الأول من المسلمين
مع علمنا بأن ذلك
الجم الغفير والجمع الكثير ممن لا يتصور عليهم التواطؤ على الباطل عادة لا
سيما لما كانوا عليه من شدة اليقين ومراعاة الدين فلو لم يعلموا منه ضرورة
أنه مبعوث إلى الناس كافة و إلى الأمم عامة من الأسود والأبيض وإلا لما
نقلوا ذلك رعاية للدين مع أنه ترك الدين وكذلك أيضا من جاء من بعدهم على
سنتهم وهلم جرا إلى زمننا هذا ولو لم يكن نبيا على العموم لزم أن يكون قد
كذب فى دعواه وأبطل فيما أتاه وذلك محال فى حق الأنبياء وحق من ثبت عصمتهم
بالمعجزات وقواطع الآيات
وعلى هذا النحو ثبوت كونه خاتم النبيين
وآخر المرسلين حيث قال لا نبى بعدى وتنزل الكتاب العزيز بمصداق ذلك تشريفا
له وتكريما فقال وخاتم النبيين وعلم ذلك فيما مضى من أهل عصره ولم يزل
تتناقلة الأمم والأعصار فى سائر الأقطار ومن لا يتصور عليهم التواطؤ على
الكذب واللهو واللعب وعلم ذلك ضرورة من قوله وكتابته فلا سبيل إلى جحده
سمعا وإن كان ذلك جائزا عقلا
وهذا آخر ما أردنا ذكره من النبوات والأفعال الخارقة للعادات
والتوكل على رب الخيرات
القانون الثامن
فى الإمامةويشتمل على طرفين
تمهيد
واعلم أن الكلام فى الإمامة ليس من أصول الديانات ولا من الأمور اللا
بديات بحيث لا يسمع المكلف الإعراض عنها والجهل بها بل لعمرى إن المعرض
عنها لأرجى حالا من الواغل فيها فإنها قلما تنفك عن التعصب والأهواء
وإثارة الفتن والشحناء والرجم بالغيب فى حق الائمة والسلف بالإزراء وهذا
مع كون الخائض فيها سالكا سبيل التحقيق فكيف إذا كان خارجا عن سواء الطريق
لكن لما جرت العادة بذكرها فى أواخر كتب المتكلمين والإبانة عن
تحقيقها فى عامة مصنفات الأصوليين لم نر من الصواب خرق العادة بترك ذكرها
فى هذا الكتاب موافقة للمألوف من الصفات وجريا على مقتضى العادات
لكننا نشير إلى تحقيق أصولها على وجه الإيجاز وتنقيح فصولها من غير احتياز
والكلام فيها يشتمل على طرفين
أطرف في وجوب الإمامة وشرائطها وبيان ما يتعلق بها
ب وطرف في بيان معتقد أهل السنة فى إمامة الخلفاء الراشدين والأئمة
المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون
الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
مذهب أهل الحق من الإسلاميين أن إقامة الإمام واتباعه فرض على المسلمين شرعا لا عقلا وذهب أكثر طوائف الشيعة إلى وجوب ذلك عقلا لا شرعا وذهب بعض القدرية والخوارج إلى أن ذلك ليس واجبا لا عقلا ولا شرعاونحن الآن نبتدئ بتقديم مذهب أهل الحق أولا ثم نشير إلى شبه المخالفين فى معرض الإعتراض وإلى وجه إبطالها عند الانفصال ثانيا
قال أهل الحق الدليل القاطع على وجوب قيام الإمام واتبعاه شرعا ما ثبت بالتواتر من إجماع المسلمين فى الصدر الأول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم على امتناع خلو الوقت عن خليفة وإمام حتى قال أبو بكر فى خطبته المشهورة بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا إن محمدا قد مات ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به فبادر الكل إلى تصديقه والإذغان إلى قبول قوله ولم يخالف فى ذلك
أحد من المسلمين ولا تقاصر عنه أحد من أرباب الدين بل
كانوا مطبقين على الوفاق ومصرين على قتال الخوارج وأهل الزيع والشقاق ولم
ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك وإن اختلفوا فى التعيين
ولم يزالوا على
ذلك مع ما كانوا عليه من الخشونة فى الدين والصلابة في اليقين وتأسيس
القواقد وتصحيح العقائد من غير أن يرهبوا فى الله لومة لائم حتى بادر
بعضهم إلى قتل الآباء والأمهات والإخوة والأخوات كل ذلك محافظة على الدين
وذبا عن حوزة المسلمين والعقل من حيث العادة يحيل الاتفاق من مثل هؤلاء
القوم على وجوب ما ليس بواجب لا سيما مع ما ورد به الكتاب العزيز من مدحهم
والسنة الشريفة فى عصمتهم فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال عليه
السلام أمتى لا تجتمع على الخطإ لا تجتمع امتى على ضلالة لم يكن الله
بالذى يجمع أمتى على الضلالة وسألت الله ألا يجمع أمتى على الضلالة
فأعطانيها إلى غير ذلك من الأحاديث وهى وإن كانت آحادها آحادا فهى مع
اختلاف ألفاظها وكثرتها تنزل منزلة التواتر فى حصول العلم بما دلت عليه من
جهة العادة قطعا وذلك على نحو علمنا بكرم حاتم وشجاعة عنترة كما بينا فيما
سلف ثم كذلك العصر الثانى والثالث وهلم جرا إلى زماننا هذا لم يزل الناس
ينسجون على منوال أهل الصدر الأول ويتبعون آثارهم ويقتفون أخبارهم على
الخط القويم والمهج المستقيم
ولذلك من نظر بعين الاعتبار وحلى
نحره بالأخبار وسلك طريق الرشاد وجانب الهوى والعناد لم يجد من نفسه
الاختلاج بمخالفة شئ من ذلك أصلا
ثم والذى يؤكد ذلك النظر إلى مستند
الإجماع فإنا نعلم أن مقصود الشارع من أوامره ونواهيه فى جميع موارده
ومصادره من شرح الحدود والمقاصات وشرع ما شرع من المعاملات والمناكحات
وأحكام الجهاد وإظهار شعائر الإسلام فى أيام الجمع والأعياد إنما هو
لاصلاح الخلق معاشا ومعادا وذلك كله لا يتم إلا بإمام مطاع من قبل الشرع
بحيث يفوضون أزمتهم فى جميع أمورهم إليه ويعتمدون فى سائر أحوالهم عليه
فأنفسهم مع ما هم عليه من اختلاف الاهواء وتشتت الآراء وما بينهم من
العداوة والشحناء قلما تنقاد بعضهم لبعض ولربما أدى ذلك إلى هلاكهم جميعا
والذى يشهد لذلك وقوع الفتن واختباط الأمم عند موت ولاة الأمر من الأئمة
والسلاطين إلى حين نصب مطاع آخر وأن ذلك لو دام لزادت الهوشات وبطلت
المعيشات وعظم الفساد فى العباد وصار كل مشغولا بحفظ نفسه تحت قائم سيفه
وذلك مما يفضى إلى رفع الدين وهلاك الناس أجمعين ومنه قيل الدين أس
والسلطان حارس الدين والسلطان توأمان
فإذا نصب الإمام من أهم مصالح
المسلمين وأعظم عمد الدين فيكون واجبا حيث عرف بالسمع أن ذلك مقصود للشرع
وليس مما يمكن القول بوجوبه عقلا
كما بيناه اللهم إلا أن يعنى بكونه واجبا عقليا أن فى فعله
فائدة وفى تركه مضرة لذلك ما لا سبيل إلى إنكاره أصلا
فإن قيل الاحتجاج بإجماع الأمة فرع تصور الإجماع وكما زعمتم أن العادة
تحيل اجتماع الأمة على الخطإ فكذلك أيضا بالنظر إلى العلماء تحيل اجتماع
الكل على حكم واحد مع ما هم عليه من اختلاف الطباع وتفاوت الأزمان
والسهولة والصعوبة فى الانقياد كما يستحيل من حيث العادة اتفاقهم كافة على
القيام أو القعود فى لحظة واحدة فى يوم واحد
ثم وإن تصور ذلك
فالاطلاع عليه لكل واحد من أهل العصر مع انقسام المجتهدين إلى معروف و إلى
غير معروف وتنائى البلدان وتباعد العمران أيضا متعذر
ثم وإن قدر أن
ذلك كله متصور لكن ما من واحد نفرضه منهم إلا ويجوز عند تقديره منفردا أن
يكون فى ذلك الحكم مخطئا وذلك الجواز لا ينتقض وإن انضاف إليه فى ذلك
الحكم من أعداد المجتهدين ما لا يحصى والذى يدل على جواز ذلك ورود النهى
بصفة العموم وهو قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأن تقولوا على
الله ما لا تعلمون ولم لم يكن ذلك منهم جائزا وإلا لما نهوا عنه
ولو كان ذلك حجة قطعية فى الشرعيات لما ذكر للزم أن يكون ذلك
حجة فى العقليات وهو خلاف الإجماع
وما ذكرتموه من الأحاديث فجملتها آحاد لا معتبر بها فى القطعيات والأمور
اليقينات وإن استدل على صحتها بإجماع الكافة عليها يلزم الدور وامتنع
الاستدلال ثم وإن كانت يقينية فمدلول اسم الأمة كل من آمن به من حين
البعثة إلى يوم القيامة وذلك غير متصور فيما نحن فيه ومع حمله على أهل
الحل والعقد من أهل كل عصر فيحتمل أنه أراد بالضلال أو الخطأ الكفر أو ما
يوجب الاعتقاد الخبيث أو نوعا آخر من أنواع الخطأ إذ تناوله لكل ضلال وخطأ
إن كان فليس إلا بطريق الظن والتخمين دون القطع واليقين
ثم وإن قدر
أن المراد به العصمة من كل خطأ والحفظ من كل زلل فلا بد أن يبين وجود
الإجماع فيما نحن فيه وما المانع من أن يكون ثم نكير وأنه لم تتحقق
الموافقة إلا من آحاد المسلمين والذى يدل على ذلك قول عمر رضى الله عنه
ألا إن بيعة أبى بكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه
أى إن بيعة أبى بكر من غير مشورة وقد وقى الله شرها فلا نعود إلى مثلها
ثم إن الإجماع لا بد وأن يعود إلى مستند من الكتاب والسنة ولو
كان للإجماع
مستند لقد كانت العادة تحيل أن لا ينقل مع توفر الدواعى إلى نقله فحيث لم
ينقل له مستند علم أنه غير واقع فى نفسه
وأيضا فإن تعاون الناس على
أشغالهم وتوفرهم على إصلاح أحوالهم وأخذهم على أيدى السفهاء منهم والقيام
بما يجب عليهم فى دينهم ودنياهم مما تحدوهم إليه طباعهم وأديانهم ويدل على
ذلك انتظام حال العربان وأهل البوادى والقفار الخارجين عن أحكام السلطان
فإذا قاموا بذلك فيما بينهم لم يكن لإقامة واحد منهم يحكم عليهم فيما
يفعلونه ويتأمر عليهم فيما يصنعونه تعين
لا سيما وما من مسئلة
اجتهادية إلا ويجوز لكل واحد من المجتهدين أن يخالفه فيها بما يؤدى إليه
اجتهاده وكيف يكون واجب الطاعة مع جواز المخالفة وما الفائدة فى نصبه نعم
إن أدى اجتهادهم إلى أن يقيموا أميرا ورئيسا عليهم يتكلف أمورهم ويرتب
جيوشهم ويحمى حوزتهم ويقوم بذلك على وجه العدل والإنصاف فلهم ذلك من غير
أن يلزمهم من تركه حرج فى الشرع أصلا ثم إن ذلك يستدعى كون الطريق متواترا
وقد عرف ما فيه فيما مضى
والجواب هو أن وقوع الاتفاق من الأمة
على وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وغير ذلك من الأحكام يكر على مقالتهم
فى منع تصوره بالإبطال وما يتخيل من امتناع الاتفاق عليه كما فرض من
القيام والقعود والأكل والشرب وغير ذلك فليس إلا لعدم الصارف والباعث له
وإلا فلو تحقق الصارف لهم إلى ذلك لم يكن بالنظر إلى العادة ممتنعا ولا
محالة أن الأمة متعبدون باتباع النصوص والأدلة الورادة من الكتاب والسنة
ومعرضون للعقاب على تركها وإهمال النظر إليها فغير بعيد أن يجدوا أنها
تصرف دواعيهم إلى الحكم بمدلوله وتبعثهم على العمل بمقتضاه ويعرف ذلك منهم
بمشافهة أو نقل متواتر كما عرف أن مذهب جميع الفلاسفة الإلهيين نفى الصفات
وكما عرف التثليث من مذهب النصارى والتثنية من مذهب جميع المجوس إلى غير
ذلك من الأمور المتفق عليها
وإن اتفق أن كان ذلك مستندا إلى قول
واحد والكل فى اتفاقهم له مقلدون وعليه معتمدون كما علم من أصحاب الشافعى
الاتفاق على منع قتل المسلم بالذمى والحر بالعبد ونحوه وكما علم من
اتفاقهم ان ذلك هو مذهب إمامهم فكذلك نعرف من اتفاق الأمة أن ذلك مستند
إلى قول نبيهم بل ومعرفة ذلك من إجماع الصدر الأول يكون أقرب وأولى فإنهم
لم يكونوا بعد قد انتشروا فى البلاد ولا تناءت بهم الأبعاد ولم يكن عددهم
مما يخرج عن الحصر لا سيما أهل الحل والعقد منهم
وتخيل الرجوع من
الأمة عما اتفقوا عليه متعذر لضرورة الخطأ فى أحد الإجماعين وقد دل السمع
والعقل على امتناعه ورجوع بعضهم وإن كان جائزا فغير قادح لكونه مخصوما
ومحجوجا بما تقدم من الإجماع السابق الذى دل العقل والسمع على
تصويبه ومع جواز الاتفاق ووقوع الإجماع يمتنع أن يكون على الحطأ
وإن كان ذلك جائزا على كل واحد أن لو قدر منفردا لما تقرر من قبل
وأقرب شاهد يخصم هذا القائل ما أشرنا إليه فى جانب حصول العلم بالتواتر فى
مسألة النبوات ولا معنى للتطويل بإعادته
وما أشير إليه من الأخبار الدلة على جواز الخطأ على الأمة فليست ناهية عن
الإجماع ليلزم ما ذكروه وإنما النهى فيها متوجه على الآحاد ثم ولو قدر ذلك
فليس النهى يستدعى وقوع المنهى عنه ولا جوازه فى نفسه فإنه تعالى قال
لنبيه فلا تكونن من الجاهلين وقال لئن أشركت ليحبطن عملك مع علمه بعصمته
وأن ذلك لا يقع منه ولا يجوز عليه
ولا شك أن العادة كما تحيل اتفاق
الأمة على الخطأ فى السمعيات كذلك فى العقليات أيضا لكننا لا نحيل تجويز
العقل لنقيض المتفق عليه من جهة العقل وأن ذلك لا تعرف استحالته إلا من
دليل عقلى أو أمر يقينى آخر ولم نتعبد بإزاحه ذلك الاحتمال الواهى بالنظر
إلى الدليل العقلى وإلا فالاجماع حجة فى العقليات بسبب كونه فى الشرعيات
وعليكم بمراعاة هذا المعنى فإنه كثيرا ما يغلط فيه ويدل على الاحتجاج به
ما أشرنا إليه من الأخبار والآثار وهى وإن كانت آحادا فلا شك أن جملتها
تنزل منزلة التواتر كما أسلفناه
وأما حمل لفظ الأمة على من تابعه
إلى يوم القيامة فهو وإن كان مقتضى اللفظ من حيث الصيغة قد خولف إجماعا
بإخراج المجانين والصبيان ومن لا تفهم له عنه ومع صرف اللفظ عن ظاهره يجب
أن ينزل على ما دل عليه الدليل وقد دلت السمعيات والقواطع من الشرعيات على
تهديد مخالف الجماعة الخارج عن السمع لهم والطاعة بإخراجه من زمرة
الموحدين وسلبه ثوب الدين مثل قوله عليه السلام من خرج عن الجماعة قيد شبر
فقد خلع ربقه الإسلام من عنقه وقوله من فارق الجماعة ومات فقد مات ميتة
جاهلية إلى غير ذلك من الآثار وقواطع الأخبار والموافقة والمخالفة
والتهديد بمثل هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم إنما تتحقق أن لو كان
المخالف معصوما فيما اتاه مصيبا فيما رآه وان تكون مم وجد دون من لم يوجد
فوجب حمل اللفظ عليه وإلا فالموافقة والمخالفة إنما تتصور فى يوم القيامة
وهو محال
وأما تخصيص الخطأ والبطلان بالكفران أو غيره من أنواع
العصيان مع ما فيه من مخالفة ظاهر اللفظ فهو مخالف لظاهر الإطلاق بالتهديد
لمخالف الإجماع من غير تفصيل ومبطل لفائدة التخصيص بالتنصيص على الأمة
وإيراد ذلك فى معرض الإكرم والإنعام والتفضل من جهة أن الواحد قد يشارك
الأمة فى ترك كل ما تقدم حمل الضلال والخطأ عليه من أنواع العصيان وإن لم
يوافقهم فى أن كل ما ذهبوا إليه واتفقوا عليه يكون صوابا وحسنا فلا سبيل
إذا إليه
وأما منع وقوع الإجماع فيما نحن فيه فبعيد لما أسلفناه
والنكير وإن كان وقوعه بالنظر إلى العقل جائزا لكنه بالنظر إلى العادة
مستحيل من جهة امتناع وقوع التواطؤ على ترك نقله مع توفر الدواعى والصوارف
إليه وليس فى قول عمر ما يدل على انتفاء وقوع الإجماع على وجوب الإمامة
كما هو مقصدنا بل وليس فيه أيضا دلالة على انتفاء وقوع الإجماع على تعيين
أبى بكر أيضا فإنه لا مانع من وقوع الإجماع على ذلك بعينه وإن قدر
الاختلاف فى التعيين
وعدم الاطلاع على مستند الإجماع فإنما يكون
قادحا أن لو كان ذلك مما تدعوا الحاجة إليه وتتوفر الدواعى على نقله وليس
كذلك فإنه مهما تحقق الاتفاق واستقر الوفاق وظهر دليل وجوب اتباعه وقع
الاكتفاء به عن مستنده ولم يبق نظر إلا فى موافقته ومخالفته ومع عدم
الحاجة إلى النظر فى المستند لكون الوفاق قد صار واجبا حتما ولازما جزما
لم تنصرف الدواعى إلى نقله ولم تتوفر البواعث على اتباعه فلا يكون عدم
الإطلاع عليه إذ ذاك قادحا كيف وإنه لا يبعد أن يكون مما لا يمكن نقله بل
يعلمه من كان فى زمن النبى عليه السلام ومشاهدا له بقرائن أحوال وإشارات
ثم أقوال وأفعال إلى غير ذلك من الأمور التى لا يمكن معرفتها إلا
بالمشاهدة والعيان
وأما اتفاق الناس على ما لأجله نصب الإمام وإن
كان ذلك جائزا فى العقل لكنه بالنظر لما لا تقبله العادة الجارية والسنة
المطردة فممتنع بدليل ما ذكرناه من أوقات الفترات وموت الملوك والسلاطين
وغير ذلك مما ذكرناه ولهذا نرى العربان والخارجين عن حكم السلطان كالذئاب
الشاردة والأسود الكاسرة لا يبقى بعضهم على بعض ولا يحافظون فى الغالب على
سنة ولا فرض ولم تك دواعيهم إلى صلاح أمورهم وتشوفهم إلى العمل بموجب
دينهم بمغن عن السلطان إذ السيف والسنان قد يفعل ما لا يفعله البرهان
ومن نظر إلى ما قررناه من الفائدة المطلوبة من نصب الإمام والغاية
المقصودة من إقامته للإسلام علم أنه لا أثر لجواز المخالفة له فيما يقع من
مسائل الاجتهاد وأن ذلك غير مقصود فيه الانقياد
وإذا ثبت وجوب
الإمامة بالسمع فهل التعيين فيها مستند إلى النص أو الاختيار فذهبت
الإمامية إلى أن مستند التعيين إنما هو النص وزعموا أن خلافة على منصوص
علها من قبل النبى صلى الله عليه و سلم بقوله أنت منى كهارون من موسى
وقوله عليه السلام بعد ما وجبت طاعة المؤمنين له وثبت أنه أحق بهم من
أنفسهم
من كنت مولاه فعلى مولاه وقوله أنت أخى وخليفتى من بعدى على
أهلى ومنجز عداتى إلى غير ذلك من الآثار والأخبار
ولربما قرروا ذلك بطريق معنوى وهو أن النبى عليه السلام إما أن يكون عالما
باحتياج الخلق إلى من يقوم بمهماتهم ويحفظ بيضتهم ويحمى حوزتهم ويقبض على
أيدى السفهاء منهم ويقيم فيهم الأحكام الشرعية على وفق ما وردت به الأدلة
السمعية على ما تقرر أو لم يكن عالما لا جائز أن يقال بكونه غير عالم إذ
هو إساءة ظن بالنبوة وقدح فى سر الرسالة وكذلك أيضا إن كان عالما ولم ينص
لا سيما والتنصيص ههنا آكد من التنصيص وإيجاب التعريف لما يتعلق بباب
الاستنجاء والتيمم على مالا يخفى وهذا وإن لزم منه صدور الخطأ من الأمة
تبع ما عينه وسومح من ادعاء انتفاء النكير فلا يخفى أن صيانة النبى عن
الخطأ أولى من صيانة الأمة التى عصمتها لم تثبت إلا بقوله وبعصمته فإذا لا
بد من التنصيص والإشارة إلى التخصيص
ولا جائز أن يقال إنه ترك الأمر
شورى فيما بين الصحابة وفوض الأمر إلى اجتهاداتهم وآرائهم ليعلم القاصر من
الفاضل والمجتهد من العيى وألا لجاز للصحابة
ألا ينصبوا إماما
أيضا ليعلم الطائع من العاصى والمنقاد للأوامر والنواهى من غيره بل ولجاز
إهمال بعثة الرسل وتفويض الأمر إلى أرباب العقول ليتميز أيضا المجتهد ومن
له النظر فى المدارك واستنباط المسالك ممن ليس كذلك وذلك مما لا يخفى
فساده كيف وأن التعيين بعد ما ثبت القول بوجوب الإمامة لازم لا محالة فهو
إما أن يستند إلى النص أو الإختبار والاجماع على التعيين لا مستند له ثم
كيف يجب على الناس طاعته وهو إنما صار إماما باقإمتهم له فإذا لابد وان
يكون التعيين واردا من قبل الشرق وصادرا من جهة السمع وهو إنما يثبت فى حق
من يدعيه دون من ينفيه هذا معتقد الشيعة وطوائف الإمامية
وأما معتقد
أهل الحق من أهل السنة وأصحاب الحديث فهو أن التعيين غير ثابت بالنص بل
بالاختيار لأنه لو ورد نصا فهو إما أن يكون نصا قطعيا أو ظنيا لا جائز أن
يكون قطعيا إذ العادة تحيل الاتفاق من الأمة على تركه وإهمال النظر لموجبه
لما سبق وإن كان ظنيا بالنظر إلى المتن والسند أو بالنظر إلى أحدهما
فادعاء العلم بالتنصيص إذ ذاك يكون محالا والاكتفاء بمحض الظن أيضا مما لا
سبيل إليه ههنا لما فيه من مخالفة الإجماع القاطع من جهة العادة
كيف وأنه لم يرد فى ذلك شئ من الأخبار ولا نقل شئ من الآثار على لسان
الثقات
والمعتمد عليهم من الرواة لا متواترا و لا آحادا غير ما نقل على
لسان
الخصوم وهم فيه مدعون وفيما نقلوه متهمون لا سيما مع ما ظهر من كذبهم
وفسقهم وبدعتهم وسلوكهم طرق الضلال والبهت بادعاء المحال ومخالفة العقول
وسب أصحاب الرسول وغير ذلك مما اشتهاره يغنى عن تعداده وإظهاره
ومما
يؤكد القول بانتفاء التنصيص إنكاره من اكثر المعتقدين لتفضيل على عليه
السلام على غيره كالزيدية ومعتزله البغداديين وغيرهم مع زوال التهمة عنهم
والشك فى قولهم وقوله عليه السلام حين خرج إلى غزوة تبوك لعلى وقد استخلفه
على قومه أنت منى كهارون من موسى معناه فى الاستخلاف على عشيرتى وقوى كما
كان هارون مستخلفا على قوم موسى من بعده وليس فى ذلك دلالة على استخلافه
بعد موته فإن ذلك مما لا يثبت لهارون المشبه به بعد موسى لأنه مات قبله فى
التيه وما ورد فى مساق الحديث من قوله إلا أنه لا نبى بعدى ليس المعنى به
بعد موتى حتى يكون ما ذكرنها مخالفا لظاهر الحديث بل معناه بعد نبوتى لا
معى ولا بعدى وذلك كما يقال لا ناصر لك بعد فلان أى بعد نصرته لا معه ولا
قبله وهو وإن افتقر إلى إضمار النبوة فما ذكروه أيضا لا بد فيه من إضمار
الموت وليس إضماره بأولى من إضماره بل ما ذكرناه أولى نفيا لإبطال فائدة
التخصيص بما بعد الموت فإنه كما قد
عرف امتناع وجود نبى آخر بعد
وفاته عرف امتناع وجوده فى حياته والاستخلاف فى حالة الحياة مما لا ينتهض
دليلا على الاستخلاف بعد الموت وإلا كان ذلك دليلا فى حق الولاة والقضاة
وكل من تولى شيئا من أمر المسلمين فى حالة حياة النبى عليه السلام وكل عذر
ينقدح ههنا فهو بعينه منقدح فى قوله عليه السلام ثم الذى يؤكد ما قلناه
أنه لو صدرت هذا العبارة عن خليفة الوقت إلى واحد من المسلمين لم يكن ذلك
عهدا له بالخلافة بعد الموت إجماعا وإن كان ذلك مما يدل على فضله وعلو
رتبته وعلى هذا يخرج قوله عليه السلام أنت أخى وخليفتى على أهلى وقاضى
دينى ومنجز عداتى وكذا قوله من كنت مولاه فعلى مولاه ثم إن لفظ المولى قد
يطلق بمعنى المحب وقد يطلق بمعنى المعتق وبمعنى الظهر والخلف وبمعنى
المكان والمقر وبمعنى الناصر ومنه قوله تعالى فإن الله هو مولاها وجبريل
وصالح المؤمنين أى ناصره ومنه قول الأخطل ... فأصبحت مولاه من الناس كلهم
... وأحرى قريش أن يهاب ويحمدا ...
أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى
وهو أظهر فى لفط المولى
ولا يمكن حمل لفظ المولى على الأولى فإن ذلك مما لا يرد فى اللغة أصلا
وقوله مأواكم النار هى مولاكم ليس المعنى به أولى بكم بل مستقركم ومكانكم
ثم
وإن كان ذلك محتملا فهو مما يمتنع حمل كلام النبى عليه لما فيه
من مراغمة الإجماع ومخالفة اتفاق المسلمين وهدم قواعد الدين
ثم إنه لو صح الاعتماد على مثل هذه الآثار فى التولية لقد كان ذلك بطريق
الأولى فيما تمسك به القائلون بالتنصيص على خلافة أبى بكر رضى الله عنه
فإنها مع ما واتاها من إجماع المسلمين أشهر وأولى وذلك مثل قوله يأبى الله
إلا أبا بكر وقوله اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر وقوله لا ينبغى
لقوم يكون فيهم أبو بكر أن يقدم عليه غيره وقال ايتونى بدواة وكتف أكتب
إلى أبى بكر كتابا وهو لا يختلف عليه اثنان وقوله إن تولوها أبا بكر تجدوه
ضعيفا فى بدنه قويا فى دينه وذلك مع ما قد ورد فى حقه من الأخبار الدالة
على فضله والآثار المشعرة بعلو
رتبته مثل قوله عليه السلام خير
أمتى أبو بكر ثم عمر وقوله من أفضل من أبى بكر زوجنى ابنته وجهزنى بماله
وجاهد معى فى ساعة الخوف وما روى عن على كرم الله وجهه أنه قال خير الناس
بعد النبى أبو بكر ثم عمر ثم الله اعلم وهذه النصوص كلها إن لم يتخيل
كونها راجحة فلا أقل من أن تكون معارضة ومساوية ومع التعارض يجب التساقط
والعمل بإجماع المسلمين والاستناد إلى اتفاق المجتهدين
وكون النبى
عليه السلام لم ينص على التعيين مما لا يشعر بعدم علمه بحاجة المسلمين إلى
من يخلفه بعده ويقوم مقامه فى إلزام الناس بما يستمر به أمر دينهم وأمر
دنياهم ومع علمه فترك التنصيص عليه إنما يكون محذورا أن لو كان به مكلفا
ومأمورا وإلا فكم من حكم فى واقعة تدعوا حاجة الناس إلى بيانه مات النبى
عليه السلام ولم يبينه من الفرائض والمعاملات والمناكحات وغير ذلك من
أحكام العبادات فإذا ترك التنصيص من النبى عليه السلام مما لا يستحيل شرعا
و لا عقلا ولا عادة بخلاف اتفاق الأمة على الخطأ كما بيناه
وليس
التنصيص على من عقدت له الإمامة بالاختيار شرطا فى طاعته فإن طاعته بعد
ذلك إنما صارت واجبة بالإجماع المستند إلى الكتاب او قول الرسول
لا إلى نفس الاختيار له أولا فإذا اشتراط استناد الاختيار إلى
التنصيص
إنما يلزم أن لو كان وجوب الطاعة مستند إليه ومعتمدا عليه وليس كذلك وبهذا
يندفع ما ذكروه من الخيال الآخر أيضا كيف وأنه لو قدر استناد الطاعة إلى
الاختيار فامتناعه واستبعاده إنما يستقيم أن لو كان ما يثبت بالاختيار لا
يتم الاختيار إلا به ولا يجب إلا بالنظر إليه لما فيه من الدور الممتنع
أما إذا كان ما يجب طاعة الإمام فيه هو غير ما يتوقف وجوب الطاعة عليه فلا
امتناع ولا استبعاد وقد تحقق بما قررناه إبطال النص وإثبات الاختيار
وإذا ثبت أن مستند التعيين ليس إلا الاختبار فذلك مما لا يفتقر إلى إجماعه
أهل الحل والعقد فإن ذلك ما لم يقم عليه دليل عقلى ولا سمعى نقلى بل
الواحد من أهل الحل والعقد والاثنان كاف فى الانعقاد ووجوب الطاعة
والانقياد لعلمنا بأن السلف من الصحابة رضوان الله عليهم مع ما كانوا عليه
من الصلابة فى الدين والمحافظة على قواعد المسلمين اكتفوا فى عقد الإمامة
بالواحد والإثنين من اهل الحل والعقد كعقد عمر لأبى بكر وعبد الرحمن بن
عوف لعثمان ولم يشترطوا إجماع من فى المدينة من اهل الحل والعقد فضلا عن
إجماع الأمصار واتفاق من فى سائر الأقطار وكانون على ذلك من المتفقين وله
من المتبعين من غير مخالفة ولا نكير وعلى ذلك انطوت الأعصار فى عقد
الإمامة فى كل حين وعليه اتفاق كافة المسلمين
قال بعض الأصحاب
ويجب أن يكون ذلك بمحضر من الشهود وبينة عادلة كفا للخصام ووقوع الخلاف
بين الأنام وادعاء مدع عقد الإمامة له سرا متقدما على عقد من كان له جهرا
عيانا وهو لا محالة واقع فى محل الاجتهاد فعلى هذا لو اتفق عقد الإمامة
لأكثر من واحد فى بلدان متعددة أو فى بلد واحد من غير أن يشعر كل فريق من
العاقدين بعقد الفريق الآخر فالواجب أن نتصفح العقود فما كان منها متقدما
وجب إقراره وامر الباقون بالنزول عن الامر فإن أجابوا وإلا قوتلوا وقتلوا
وكانوا خوارج بغاة وإن لم يعلم السابق وجب إبطال الجميع واستأنف عقد لمن
يقع عليه الاختيار كما إذا زوج أحد الوليين موليته من شخص وجهل العقد
السابق منهما
ولا خلاف فى أنه لا يجوز عقد الإمامة لشخصين فى صقع
واحد متضايق الأقطار ومتقارب الأمصار لما فيه من الضراء ووقوع الفتن
والشحناء وأما إن تباعدت الأقطار وتناءت الديار بحيث لا يستقل إمام واحد
بتدبيرها والنظر فى أحوالها فقد قال بعض الأصحاب إن إقامة إمام آخر فى محل
الاجتهاد
وليس الاختيار لعقد الأمامة جائزا على التشهى والإيثار
بل لا بد وأن يكون للمعقود له صفات وخصوصيات وهى أن يكون من العلم بمنزلة
قاض من قضاة المسلمين وأن يكون له من قوة البأس وشدة المراس قدر ما لا
يهوله إقامة الحدود وضرب الرقاب وإنصاف المظلوم من الظالم وأن يكون بصيرا
بأمور الحرب وترتيب الجيوش وحفظ الثغور ذكرا حرا مسلما عدلا ثقة فيما يقول
لاتفاق الأمة على ذلك ومحافظة على ما لأجله نصب الأمام
ومما دل
السمع على اشتراطه أن يكون قرشيا وذلك نحو قوله عليه السلام الأئمة من
قريش وقوله قدموا قريشا ولا تقدموا عليها وقوله إنما الناس
تبع
لقريش فبر الناس تابع لبرهم وفاجرهم تابع لفاجرهم وأيضا فإن الأئمة من
السلف مطبقون على ان الإمامة لا تصلح إلا لقريش وتلقيهم لهذه الأخبار
بالقبول واحتجاج بعضهم على بعض بها وقول عمر رضى الله عنه عن سالم مولى
أبى حذيفة لو كان حيا لما تخالجنى فيه شك فإنما كان لأنه قد قيل إنه كان
ينتسب إلى قريش ولعمرى إن مثل هذا الشرط واقع فى محال الاجتهاد
وقد
زادت الشيعة شروطا أخر وهو أن يكون من بنى هاشم معصوما عالما بالغيب لأنا
نأمن بمبايعتهم من النيران وغضب الرحمن وهذه الشروط مما لم يدل عليها عقل
ولا نقل ثم إن اشتراط الهاشمية مما يخالف ظاهر النص وإجماع الأمة على عقد
الامامة لأبى بكر وعمر وبه يبطل اشتراط العصمة والعلم بالغيب أيضا ثم ولو
اشترطت العصمة فى الإمام لأمن متبعيه لوجب اشتراطها فى حق القضاة والولاة
ايضا فإنه ليس يلى ببيعته أشياء أكثر مما يلى خلفاؤه وأولياؤه
ثم كيف يدعى اشتراط العصمة فى الإمامة مع الاتفاق على عقد الإمامة للخلفاء
الراشدين واعترافهم بأنهم ليسوا بمعصومين حتى إن كل واحد منهم قد
كان يرى
الرأى ثم يرجع فيه ويطلب الآثار والأخبار كطلب آحاد الناس وبعضهم يخالفه
البعض وذلك كما نقل عن على عليه السلام أنه قال فى حق أمهات الأولاد اتفق
رأيى ورأى عمر على أن لا يبعن والآن فقد رأيت بيعهن وبالضرورة عند
اختلافهما لا بد من وقوع الخطأ فى حق أحدهما ويخرج عن أن يكون معصوما
بل وفى ذلك دلالة على انتفاء العصمة عن على أيضا فإنه لا بد وأن يكون
مصيبا فى إحدى الحالتين مخطئا فى الأخرى ومع تطرق الخطأ إليه لا يكون
معصوما
فإذا قد بان أن ما ذكروه ليس بمتعين فى الشرع ولا وارد فى
السمع بل مهما ظهر بالإشارات والعلامات والبيان من الأفعال والأقوال ما
يدل ظاهرا على استجماع ما شرطناه فى شخص ما جاز عقد الإمامة له لما أشرنا
إليه ونبهنا عليه من قبل ويكون حكمه فى معرفة ذلك منه حكم القضاة والولاة
وكل من يتولى أمرا من أمور المسلمين
ولهم أن يخلعوه وإن شرط غير ذلك
إذا وجد منه ما يوجب الاختلال فى أمور الدين وأحوال المسلمين وما لأجله
يقام الأمام وان لم يقدروا على خلعه وإقامة غيره لقوة شوكته وعظم تأهبه
وكان ذلك مما يفضى إلى فساد العالم وهلاك النفوس
وكانت المفسدة فى مقابله آكد من المفسدة اللازمة من طاعته أمكن
ارتكاب أدنى المحذورين دفعا لأعلاهما
وإن كان ما طرأ عليه هو الكفر بعد الإسلام والردة بعد الإيمان فحالهم فى
طاعته والانقياد إلى متابعته لا تتقاصر عن حال المكره على الردة أو القتل
بالنسبة إلى المكره
وعلى هذا إن لم يوجد فى العالم مستجمع لجميع
شروط الإمامة بل من فقد فى حقه شئ كالعلم أو العدالة ونحوها فالواجب أن
ينظر إلى المفسدة اللازمة من إقامته وعدم إقامته ويدفع أعلاهما بارتكاب
أدناهما إذ الضرورات تبيح المحظورات وذلك كما فى أكل الميتة بالنسبة إلى
حالة الإضطرار ونحوه هذا تمام الطرف الأول
الطرف الثانى
فى معتقد أهل السنة فى الصحابة وإمامة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديينولا خلاف فيما بين أهل الحق أن أبا بكر كان إماما حقا وذلك باتفاق المسلمين على إقامته واجتماع اهل الحق والعقد على إمامته واتباع الناس له فى أيام حياته وموافقة الصحابة له فى غزواته ونصبه للولا والحكام وتنفيذ أوامره ونواهيه فى البلدان وذلك مما لا قبل بمدافعته ولا سبيل إلى مجاحدته وأن من تخلف عن بيعته فى مبدأ الأمر مثل على وغيره لم يكن عن شقاق ونفاق وإنما كان لعذر وطروء أمر والإ فلو كان ذلك للشقاق والخروج عن الوفاق لأمر يكرهونه ولا يرتضونه لقد كان ذلك مما يسارعونه إلى إنكاره ويبالغون فى إظهاره لا سيما فى حق الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وكانوا مع ما هم عليه من قوة اليقين والصلابة فى الدين لا يراقبون فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لومة اللائمين ولا خوف المخوفين ولو كان ذلك مما
ظهر لقد كانت العادة مما تحيل تطابق الأمة على ترك نقله مع توفر
الدواعى عليه وصرف الهمم إليه واتفاق الأمة على ذلك مما يدل ضرورة على
كونه أهلا للإمامة ومستجمعا لشرائطها أيضا
ثم كيف ينكر ذلك مع ما
عرف من نسبه وعدالته وعمله وشجاعته وتصرفه فى البلاد وإصلاح نظام العباد
بالآثار الدالة عليها والعلامات الواضحة المشيرة اليها على ما تواترت به
الأخبار وتتالت به الآثار على ألسنة الثقات الأخيار وغير ذلك مما يكل عنه
اللسان ويتقاصر عن تسطيره البيان فوجب الاكتفاء بشهرتها عن ذكرها
ولكن قد يشكك بعض أهل الضلال ومن لم يثبت له قدم راسخ فى الاستنباط
والاستدلال باستقالة أبى بكر من الامامة وبقوله وليتكم ولست بخيركم وقول
عمر إن بيعة أبى بمكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه
هذا وأمثاله مما يتمسك به من لا خلاق له من الروافض والإمامية الخارجين عن
ربقة الدين
وليس ذلك عند من له أدنى حظ من التفطن مما يؤثر خيالا
ولا إشكالا فإن الاستقالة لا تدل على عدم الاستحقاق لا سيما مع اتفاق
الأمة على كونه مستحقا بل لعل ذلك لم يكن
إلا للفرار من حمل
أعباء أمور المسلمين والخوف من شدة التكليف والتقليد لتدبير أمور الدين أو
الامتحان لتعرف الموافق من المخالف أو غير ذلك من الاحتمالات ومع ذلك فلا
ينهض الاقتيال شبهة فى درء الاستحقاق وكذلك قوله وليتكم ولست بخيركم فإنه
يحتمل أنه أراد التولية فى الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم
ومن المعلوم أنه لم يكن إذ ذاك أخير من قوم فيهم الرسول ويكون فائدة ذكر
ذلك الاحتجاج على جواز توليته بعد الرسول بطريق التنبيه بالأدنى على
الأعلى ويحتمل أنه أرد بقوله ولست بخيركم أى فى العشيرة والقبيلة إذ
الهاشمى أفضل من القرشى وإن لم يكن شرطا فى الإمامة ويحتمل انه أراد ذلك
قبل التولية وفى الجملة ليس يلزم من نفى الأفضلية أن يكون مفضولا بل من
الجائز أن يكون مساويا ومع ذلك فعقد الإمامة له يكون جائزا بالاتفاق
وقول عمر رضى الله عنه مع ما كان يحتج على الناس بإمامته ويدعوهم إلى
طاعته وتمسكه فى ذلك بعهد أبى بكر وولايته لا يجوز أن يحمل على أن خلافته
كانت باطلة وإلا فان ذلك مما يوجب الخبط فى قوله والهجر فيه ولا يخفى على
أحد ما كان عمر عليه من الأمانة والديانة والعقل الكامل والرزانة فمعنى
قوله كانت فلتة أى عن غير مشورة وقوله وقى الله شرها أى شر الخلاف فيها
وقوله فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه أى إلى مثل مخالفة الأنصار فى نصبهم
إمامين وقولهم منا أمير ومنكم امير ومع هذه الاحتمالات وانقداح هذه
الخيالات يخرج ما ذكروه
عن أن يكون قادحا ويلزم القول بإمامته والاعتراف بصحته توليته
على ما وقع عليه اتفاق الأمة ومعتقد أهل السنة
وأما باقى الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم أجمعين
فالسبيل إلى إثبات إمامتهم وصحة توليتهم واستجماعهم لشرائط الإمامة كإثبات
ذلك فى حق أبى بكر رضى الله عنه وصحة عهد أبى بكر إلى عمر والشورى وعقد
عبد الرحمن ابن عوف لعثمان فإنها تستند إلى الإجماع أيضا وكذا الحكم على
قتلة عثمان ومقاتلى على بكونهم بغاة فإن أسباب حل القتل وجواز قتال الإمام
محصورة ولم يوجد شئ منها قى حق عثمان ولا على عليه السلام
ومع هذا
كله فالواجب أن يحسن الظن بأصحاب الرسول وأن يكف عما جرا بينهم وألا يحمل
شئ مما فعلوه أو قالوه إلا على وجهة الخير وحسن القصد وسلامة الاعتقاد
وانه مستند إلى الاجتهاد لما استقر فى الأسماع وتمهد فى الطباع ووردت به
الأخبار والآثار متواترة وآحاد من غرر الكتاب والسنة واتفاق الأمة على
مدحهم والثناء عليهم بفضلهم مما هو فى اشتهاره يغنى عن إظهاره وأن أكثر ما
ورد فى حقهم من الأفعال الشنيعة والأمور الخارجة عن حكم الشريعة فلا أصل
لها إلا تخرصات أهل الأهواء وتصنعات الأعداء كالروافض والخوارج وغيرهم من
السفساف ومن لا خلاق له من الأطراف وما ثبت نقله ولا سبيل إلى الطعن فيه
فما كان يسوغ فيه الاحتمال والتأويل فيه بحال فالواجب أن يحمل على أحسن
الاحتمالات وأن ينزل على أشرف التنزيلات وإلا فالواجب
الكف عنه
والانقباض منه وان يعتقد أن له تأويلا لم يوصل إليه ولم يوقف عليه إذ هو
الأليق بأرباب الديانات وأصحاب المروءات وأسلم من الوقوع فى الزلات ولكون
سكوت الإنسان عما لا يلزمه الكلام فيه أرجى له من أن يخوض فيما لا يعنيه
لا سيما إذا احتمل ذلك الزلل والوقوع بالظن والرجم بالغيب فى الخطل
ويجب مع ذلك أن يعتقد أن أبا بكر أفضل من عمر وأن عمر أفضل من عثمان وان
عثمان أفضل من على وأن الأربعة أفضل من باقى العشرة والعشرة أفضل ممن
عداهم من أهل عصرهم وأن اهل ذلك العصر أفضل ممن بعدهم وكذلك من بعدهم أفضل
من يليهم وأن مستند ذلك ليس إلا الظن وما ورد فى ذلك من الآثار وأخبار
الآحاد والميل من الأمة إلى ذلك بطريق الاجتهاد
وفيما ذكرناه غنية للمبتدئين وشفاء للمنتهين عند من نظر بعين الاعتبار وله
قدم راسخ فى الاختبار
والمسئول من بارئ النسم ومعيد الرمم أن ينيلنا فائدته ويعقبنا عائدته حين
الفقر والفاقة وضعف الطاقة فى يوم القصاص حيث لات حين مناص وأن يصلى على
صفوته من الرسل محمد وآله وأصحابه إنه أرجى مسئول وأعطف مأمول