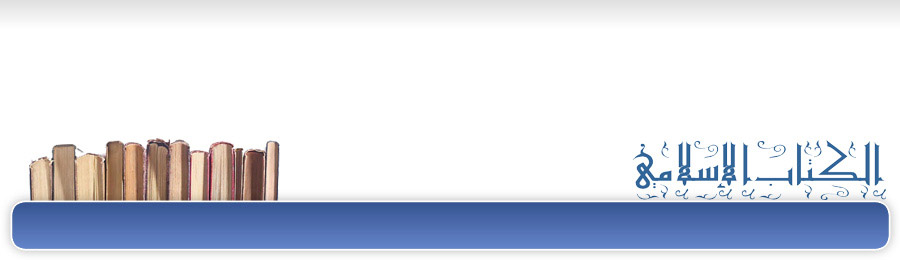كتاب : مسائل الانتقاد
المؤلف : ابن شرف القيرواني
بسم الله الرحمن الرحيم
رب أعن برحمتك
قال أبو عبد الله محمدُ بنُ شَرَف القيرواني: هذه أحاديثُ صنعتُها مختلفة الأنواع، مُؤتلفة في الأسماع؛ عربيّات المَواشِم، غَريبات التراجم، واختلفتُ فيها أخباراً فصَيحاتُ الكلام، بديعاتُ النظام؛ لها مَقاصدُ ظِراف، وأسانيد طِرَاف؛ يَروق الصغيرَ معناها، والكبيرَ مَغْزاها. وعزوْتُها إلى أبي الرِّيان الصَّلْت بن السّكْن، من سَلامات، وكان شيخاً هِمّا في اللسان، وبدراً تِمّاً في البَيان؛ قد بقي أحقابا، ولقي أعقابا؛ ثم ألقتْه إلينا من باديته الأزمات، وأوردته علينا المعجزات، فمَتَحْنا من علمه بحراً جارياً، وقدحنا من فَهمه زَنْداً واريا؛ وأدرنا مِن برّه طَرَفا، واجتنينا من ثمره طُرَفا؛ ونحن إذ ذاك والشباب مُقْتَبل، وغفلةُ الزمان تَهْتبل؛ واحتذيتُ فيما ذهبتُ إليه، ووقع تعرِيضي عليه؛ مِن بث هذه الأحاديث ما رأيتُ الأوائل قد وضعتْهن في كتاب كليلة ودمنة، فأضافوا حِكَمه إلى الطير الحوائم، ونَطقوا به على ألسنة الوَحش والبهائم، لتتعلق به شهواتُ الأحداث، وتُستعذب بسَمره ألفاظُ الحدّاث. وقد نحا بذا النحو سهل بن هارون الكاتب في تأليفه كتاب " النمر والثعلب " . وهو مشهور الحكايات، بديع المراسلات، مليح المكاتبات. وزوّرَ أيضاً بديعُ الزمان الحافظ الهمذاني، وهو الأستاذ أبو الفضل أحمد بن الحُسين مقاماتٌ كان يُنشئها بديهاً في أواخر مجالسه ويَنسبُها إلى رواية رواها له يُسميه عيسى بن هشام، وزعم أنه حدّثه بها عن بليغِ يُسميه أبا الفتح الإسكندري، وعددها، فيما يزعم رُواتها، عشرون مقامة. إلا أنها لم تصل ه0ذه العدّة إلينا، وهي مُتضمنة معانيَ مختلفة، ومَبنيّة على معاني شتى غير مؤتلفة؛ لينتفعَ بها من الكُتاب المحاضرين مَن صرفها من هَزل إلى جدّ، ومن ندّ إلى ضد.فأقمت من هذا النحو عشرين حَديثاً، أرجو أن يتبيّن فضْلها، ولا تُقَصِّرُ عما قبلها. ولعمري ما أشكرُ من نفسي، ولا أُثني على شيءٍ من حسِّي، إلا ظَفَري بالأقل مما حاولتُه، على ما أضرمته نيرانُ الغربة من قلب، وثلمته صَعقات الفتنة من لُبِّي؛ وقطعتْ أهوال البر والبحر من خَواطري، وأضعفت الوحشةُ من غَرائزي وبصائري. لكنَّ نية القاصد وسَعة المقصود، أعانا ذا الودّ على إتحاف المَودود. والله أسأل توفيقاً، ينهج لنا إلى الرّشد طريقاً. فمنها: قال محمد: وجاريتُ أبا الريان في الشعر والشعراء ومنازلهم في جاهليتهم وإسلامهم، واستكشفته عن مَذهبه فيهم، ومَذاهب ءبقته في قديمهم وحديثهم. فقال: الشعراء أكثرُ من الإحصاء، وأشعارهم أبعد من شقة الاستقصاء. فقلت: لا أعنتك بأكثر من المشهورين، ولا أذاكرك إلا في المذكورين؛ مثل الضليل، والقتيل؛ ولبيد، وعبيد، والنوابغ والعشي، والأسود بن يعفر وصخر الغي؛ وابن الصمة دريد، والراعي عبيد، وزيد الخيل، وعامر بن الطُّفيل، والفرزدق وجرير، وجميل بن معمر وكثير، وابن جندل وابن مقبل، وجرول والأخطل؛ وحسان في هجائه ومَدحه، وغيلان في ميته وصيدحه؛ والهذلي بن ذُؤيب، وسحيم ونصيب؛ وابن حِلّزة الوائلي، وابن الرقاع العاملي، وعنترة العبسي، وزهير المري، وشعراء فزارة، ومفلقي بن زُرارة، وشعراء تغلب، ويثرب. وأمثال هذا النمط الأوسء كالرم÷اح، والطِرماح؛ والطثري والدميني، والكُميت الأسدي؛ وحميد الهلالي، وبشار العُقيلي؛ وابن ابي حفصة الأموي، ووالبة الأسديّ، وابن جَبلة الحلمي، وأبي نُواس الحكمي؛ وصريع الأنصاري، ودِعبل الخُزاعي؛ وابن جهم القُرشي، وحبيب الطائي، والوليد البحتري، وابن المُعتزّ العباسي؛ وعليّ بن العبّاس الرومي، وابن رغبان الحمصي، ومن الطبقة المتأخرة في الزمان، المتقدمة في الإحسان، كأبي فراس بن حمدان، والمتنبي بن عبدان؛ وابن جدار المصري، وابن الأحنف الحنفي، وكُشاجَم الفارسي، والصنوبريّ الحلي؛ ونصر الخبزرزّي، وابن عبد ربه القُرطبي؛ وابن هانيء الأندلسي، وعلي بن العباس الإيادي التُونسي، والقَسْطلي.
قال أبو الريَّان: لقد سَمّيتَ مشاهير، وأبقيت الكثير قلت: بلى،
ولكن ما عندك فيمن ذكرت؟ قال: أما الضِلّيل مؤسّسُ الأساس، وبنيانه عليه
الناس؛ كانوا يقولون )أسيلة الخد(، حتى قال )أسيلةَ مجرى الدمع(، وكانوا
يقولون )تامة القامة( و)طويلة القامة( و " جَيْدآء " و " تامّة العنق "
وأشباه هذا حتى قال: " بعيدة مهوى القرْط " . وكانوا يقولون في الفرس
السابق: " يلحق الغزال والظليم " وشبهه، حتى قال: " قَيْد الأوابد " .
ومثل هذا له كثير. ولم يكن قبله من فطن لهذه الإشارات والاستعارات غيره.
فامتثلوه بعده. وكانت الأشعار قبل سواذج، فبقيت هذه جدداً وتلك نواهج؛ وكل
شعر بعد، ما خلاها فغير رائق النسج، وإن كان النهج.
وأما طرفة فلو طال عمره، لطال شعره، وعلا ذكره. ولقد خُصّ بأوفر نصيب من
الشعر، على أيسر نصيب من العمر؛ فملأ أرجاء ذلك النصيب بصنوفٍ من الحكمة،
وأوصاف من علو الهمة والطبع، معلم حاذق، وجواد سابق.
وأما الشيخ أبو عقيل فشعره ينطق بلسان الجزالة، عن جنان الأصالة، فلا تسمع
له إلا كلاماً فصيحاً، ومعنى مبيناً صريحاً؛ وإن كان شيخ الوقار، والشرف
والفخار؛ لبادئات في شعره وهي دلائله، قبل أن يعلم قائله.
وأما العبسي فمُجيدٌ في أشعاره، ولا كمعلقته فقد انفرد بها انفرادَ سهيل،
وغبر في وجوه الخيل؛ وجمع فيها بين الحلاوة والجزالة، ورقة الغزل وغلظة
البسالة؛ وأطال وأستطال، وأمن السآمة والكلام.
وأما زهير فأي زهير، بين لهوات زهير؛ حكم فارس، ومقامات الفوارس؛ ومواعظ
الزهاد، ومعتبرات العباد؛ ومدح يكسب الفخار، ويبقى بقاء الأعصار؛ ومعاتبات
مرة تحسن، ومرة تخش؛ وتارة تكون هجواً، وطوراً تكاد تعود شكراً.
وأما ابن حِلّزة فسهل الحزون، قام خطيباً بالموزون؛ والعادة أن يسهل شرح
الشعر بالنثر، وهذا أسهل بالوعر؛ وذلك مثل قوله:
أبْرَموا أمرَهم عِشاءً فلمّا ... أصبحوا أصبحتْ لهم ضَوْضاء
مِن مُنادٍ ومن مُجيبٍ ومن تَصْ ... هالِ خَيْلٍ خلالَ ذاك رُغاء
فلو أجتمع كلُّ خطيب ناثر، من أول وآخر؛ يصفون سفراً نهضوا بالأسحار،
وعسكراً تنادى بالنهوض إلى طلب الثار: ما زادوا على هذا إن لم ينقصوا منه،
ولم يقصروا عنه. وسائر قصيدته في هذا السلك شكاية وطلاب نصفة، وعتاب في
عزة وأنفة؛ وهو من شعراء وائل، وأحد أسنة هاتيك القبائل.
وأما ابن كلثوم فصاحب واحدةٍ بلا زيادة؛ أنطقه بها عزُّ الظفر، وهزه فيها
جن الأشر؛ فقعقعت رعوده في أرجائها، وجَعجعت رحاهُ في أثنائها؛ وجعلتها
تغلبُ قبلتها التي تُصلّي إليها، وملتها التي تعتمد عليها؛ فلم يتركوا
إعادتها، ولا خلعوا عبادتها؛ إلا بعد قول القائل:
ألهي بنى تَغْلبٍ عن كُلِّ مَكْرمُةٍ ... قصيدةٌ قالها عمرُو بنُ كلثوم
على أنها من القصائد المحققات، وإحدى المعلقات.
أما النابغة زياد، فأشعاره الجياد، لم تخرج عن نار جوانحه حتى تناهى
نضجها، ولا قطعت من منوال خواطره حتى تكاثف نسجها، لم تهلهلها ميعة
الشباب، ولا وهاء الأسباب، ولا لؤم الاكتساب فشعره وسائط سلوك، وتيجان
ملوك.
وأما النابغة الجعدي، فنقي الكلام، شاعر الجاهلية والإسلام؛ واستحسن شعره
أفصح الناطقين، ودعا له أصدق الصادقين؛ وكان شاعراً في الافتخار والثناء،
قصير الباع لشرفه عن تناول الهجاء؛ وكان مغلوباً فيه في الجاهلية، وطريد
ليلى الأخيلية.
وأما العُشى بأجمعهم فكلهم شاعر، ولا كميمون بن قيس شاعر المدح والهجاء،
واليأس والرخاء؛ والتصرف في الفنون، والسعي في السهول والحزون؛ نفق مدحه
بنات المحلق وكان في فقر ابن المذلق وأبكى هجوه علقمة، كما تبكي الأمة.
وأما الأسود بن يَعفُر فأشعرُ الناس إذا ندب دولةً زالت، أو بكى حالة
حالت؛ أو وصف ربعاً خلا بعد عمران، أو داراً درست بعد سكان؛ فإذا سلك هذا
السبيل، فهو من حشو هذا القبيل؛ كعمرو وزيد، وسعد وسعيد.
وأما حسان، فقد أجتث بواكر غسان؛ ثم جاء الإسلام. وانكشف الإظلام؛ فحاجج
عن الدين، وناضل عن خاتم النبيين؛ فشعر وزاد، وحسن وأجاد؛ إلا أن الفضل في
ذلك لرب العالمين، وتسديد الروح الأمين.
وأما دريد بن الصمة، فصمة صمم، وشاعر جشم، وغزل عرم؛ وأول من تغزل في
رثاء، وهزل في حزن وبكاء؛ فقال في معبد أخيه، قصيدته المشهورة يرثيه: أرث
جديد الخل من أمّ مَعْبد
وهي من شاجيات النوائح، وباقيات المدائح.
وأما الراعي عُبيد فجبل على وصف الإبل فصار بالرعي يُعرف، ونسي ماله من
الشرف.
وأما زَيْدُ الخيل فخطيب سجاعة، وفارس شجاعة؛ مشغول بذلك، عما سواه من
المسالك.
وأما عامر بن الطفيل فشاعرهم في الفخار، وفي حماية الجار؛ وأوصفهم لكريمة،
وأبعثهم لحميد شيمة.
وأما ابن مقبل فقديمٌ شعره، وصليبٌ نجره؛ ومغلي مدحه، ومعلي قدحه.
وأما جرول فخبيث هجاؤه، شريفٌ ثناؤه؛ رفع شعره من الثرى، وحط من الثريا،
واعاد بلطافة فكره، ومتانة شعره؛ قبيح الألقاب، فخراً يبقى على الأحقاب،
ويتوارث في الأعقاب.
وأما أبو ذؤيبٌ فشديد، أمير الشعر حكيمهُ، شغله فيه التجريبُ حديثه
وقديمه؛ وله المرثية النقية السبك، المتينة الحبك؛ بكى فيها بنيه السبعة،
ووصف الحمار فطوَّل، وهي التي أولها: أمِنَ المَنونِ وَرَيْبها تتوجّع
وأما الأخطلُ فسَعدٌ من سعود بني مروان، صفت لهم مرآة فكره، وظفروا
بالبديع من شعره؛ وكان باقعةَ من حاجاه، وصاعقةَ من هاجاه.
وأما الدرامي همام فجوهر كلامه، وأغراض سهامه، إذا افتخر بملك ابن حنظلة،
وبدارم في شرف المنزلة. وأطول ما يكون مدى إذا تطاول اختيار جرير عليه
بقليله على كثيره، وبصغيره على كبيره؛ فإنه يصادمه حينئذ ببحر ماد،
ويقاومه بسيفٍ حاد.
وأما ابن الخطفى فزهدٌ في غزل، وحجر في جدل؛ يسبح أولاً في ماء عذب، ويطمح
آخراً في صخر صلب؛ كلب منابحةٍ، وكبش مناطحة؛ لا تفل غرب لسانه مطاولة
الكفاح، ولا تُدمى هامته مداومة النطاح؛ جارى السوابق بمطية، وفاخر غالب
بعطية؛ وبلغته بلاغته إلى المساواة، وحملته جرأته على المجاراة، والناس
فيهما فريقان، وبينهما عند قوم فرقان.
وأما القيسان وطبقتهما فطبقة عشقةٍ وتوقة، استحوذت الصبابة على أفكارهم،
واستفرغت دواعي الحب معاني أشعاره؛ فكلهم مشغول بهواه، لا يتعداه إلى سواه.
وأما كُثَيِّر، فحسن النسيب فصيحه، نظيف العتاب مليحه، شجي الأغتراب
قريحه؛ جامع إلى ذلك رقائق الظفراء، وجزالة مدح الخلفاء.
وأما الكميت والرماح، ونصيب والطرماح، فشعراء معاصرة، ومناقضات ومفاخرة؛
فنصيب أمدح القوم، والطرماح أهجاهم؛ والرماح أنسبهم نسيباً، والكميت أشبهم
تشبيهاً.
وأما بشار بن برد، فأول المحدثين، وآخر المخضرمين؛ وممن لحق الدولتين.
عاشق سمع، وشاعر جمع؛ وشعره ينفق عند ربات الحجال، وعند فحول الرجال؛ فهو
يلين حتى يستطعف، ويقوى حتى يستنكف؛ وقد طال عمره، وكثر شعره، وطما بحره،
ونقب في البلاد ذكره.
وأما ابن ابي حفصة فمن شعراء الدولتين، وممن حظي بالنعمتين، ووصل إلى
الغنى بالصلتين، وكان درب المغول، ذرب المقول؛ والد شعراء ومنجب فصحاء.
وأما أبو نواس، فأول الناس في خرم القياس، وذلك أنه ترك السيرة الأولى،
ونكب عن الطريقة المثلى؛ وجعل الجد هزلا، والصعب سهلا؛ فهلهل المسرد،
وبلبل المنضد، وخلخل المنجد؛ وترك الدعائم، وبنى على الطامي والعائم؛
وصادف الأفهام قد نكلت. وأسباب العربية قد تخلخلت وانحلت؛ والفصاحات
الصحيحة قد سئمت وملت؛ فمال الناس إلى ما عرفوه، وعلقت نفوسهم بما ألفوه.
فتهادوا شعره، وأغلوا سعره؛ وشغفوا بأسخفه، وكلفوا بأضعفه. وكان ساعده
أقوى، وسراجه أضوى، لكنه عرض الأنفق، وأهدى الأوفق؛ وخالف فشهر وعرف،
وأغرب فذكر واستظرف. والعوام تختار هذه الأعلاق، وأسواقهم أوسع الأسواق؛
فشعر أبي نواس، نافق عند هذه الأجناس، كاسد عند أنقد الناس. وقد فطن إلى
استضعافه، وخاف من استخفافه؛ فاستدر بفصيح طروده، طرفا حد اللسان وحدوده.
وهو محدود في كثرة التظاهر، على من غض منه بالحق الظاهر، ليس إلا لخفة روح
المجون، وسهولة الكلام الضعيف الملحون؛ على جمهور العوام، لا على خواص
الأنام.
وأما صريع فكلامه مرصع، ونظامه مصنع، وجملة شعره صحيحة الأصول، مصنعة
الفصول، قليلة الفضول.
وأما العباس بن الأحنف فمعتزلٌ بهواه، وبمعزلٍ عما سهواه؛ دفع نفسه عن
المدح والهجاء، ووضعها بين يدي هواه من النسا؛ قد رقق الشغف كلامه، وثقفت
قوة الطبع نظامه؛ فله رقة العشاق، وجودة الحذاق.
وأما دعبل، فمدّ يد مقبل؛ اليوم مدح، وغداً قدح؛ يجيد في الطريقتين، ويسيء
في الخليقتين؛ وله أشعار في العصبية. وكان شاعر علماء، وعالم شعراء.
وأما علي بن الجهم، فرشيق الفهم، راشق السهم: استوصل بشعره
الشرفاء، ونادم الخلفا؛ وله في الغزل الرصافية، وفي العتاب الدالية؛ ولو
لم يكن له سواهما، لكان أشعر الناس بهما.
وأما الطائبي حبيب، فمتكلف إلا أنه يصيب، ومتعب، لكن له من الراحة نصيب،
وشغله المطابقة والتجنيس، وحبذا ذلك أو بيس؛ جزل المعاني، مرصوص المغاني؛
ومدحه ورثاؤه، لا غزله وهجاؤه؛ طرفا نقيض، وخطب سماءٍ وحضيض؛ وفي شعره علم
جم من النسب، وجملة وافرة من أيام العرب؛ وطارت له أمثال، وحفظت له أقوال؛
وديوانه مقروء، وشعره متلو.
قال ابن بسام: أما صفته هذه لأبي تمام فنصفة لم يثن عطفها حمية، ولا تعلقت
بذيلها عصبية، حتى لو سمعها حبيب لاتخذها قبلة واعتمدها ملة؛ فما لام من
أدب وإن أوجع، ولا سب من صدق وإن أقذع.
وأما البحتري فلفظه ماءٌ ثجاج، ودر رجراج، ومعناه سراج وهاج، على أهدى
منهاج؛ يسبقه شعره، إلى ما يجيش به صدره؛ يسر مراد، ولين قياد؛ إن شربته
أرواك، وإن قدحته أوراك؛ طبع لا تكلف يعييه، ولا العناد يثنيه؛ لا يمل
كثيره ولا يستكلف غزيره، ولم يهف أيام الحلم، ولم يصف زمن الهرم.
وأما ابن المعتز فملك النظام، كما ملك الأنام؛ له التشبيهات المثلية،
والاستعارات الشكلية؛ والإشارات السحرية، والعبارات المجرية؛ والتصاريف
الصوفية، والطرائق الفنونية؛ والافتخارات الملوكية، والهمات العلوية،
والغزل الرائق، والعتاب الشائق؛ والوصف الحسن الفائق:
وخيرُ الشّعر أكرمُه رجالاً ... وشرُّ الشعر ما قال العَبيدُ
وأما ابن الرومي فشجرةُ الإختراع، وثمرة الإبتداع؛ وله في الهجاء، ما ليس
له في الإطراء؛ فتح فيه أبواباً، ووصل منه أسباباً، وخلع منه أثواباً،
وطوق فيه رقاباً، يبقين أعماراً وأحقاباً؛ يطول عليها حسابه، ويمحق بها
ثوابه؛ ولقد كان واسع العطن، لطيف الفطن، إلا أن الغالب عليه ضعف المريرة،
وقوة المرة.
وأما كشاجم فحكيمٌ شاعر، وكاتبٌ ماهر؛ له في التشبيهات غرائب، وفي
التأليفات عجائب، يجيد الوصف ويحققه، ويسبك المعنى فيرققه ويروقه.
وأما الصنوبري ففصيح الكلام غريبه، مليح التشبيه عجيبه؛ مستعمل لشواذ
القوافي، يغسل كدرتها بمياه فهمه الصوافي؛ فتجلو وتدق، وتعذب وترق؛ وهو
وحيد جنسه في صفة الأزهار، وأنواع الأنوار. وكان في بعض أشعاره يتخالع،
وفي بعضها يتشاجع؛ وقد مدح وهجا، ونثر وشجا؛ وأعجب شعره وأطرب، وشرق وغرب؛
ومدح من أهل إفريقية أمير الزاب، جعفر بن علي منفق سوق الآداب؛ فوصله بألف
دينار، بعثها إليه مع ثقات التجار.
وأما الخبزرزي فخليع الشعر ماجنه، رائق اللفظ بائنه؛ كثيرةٌ محاسنه، صحيحة
أصوله ومعادنه؛ رائقة البزة، مائلة إلى العزة؛ تسليه عن الحب الخيانة،
ويروقه الوفاء والصيانة؛ وله على خشونة خلقه، وصعوبة خلقه؛ اختراعاتٌ
لطيفة، وابتداعات ظريفة؛ في ألفاظ كثيفة. وفصول قليلة الفضول نظيفة؛ حتى
إن بعض كبراء الشعراء اهتدم أشياء من مبانيه، واهتضم طرفا من معانيه؛ وهو
من معاصريه، فقل من فطن لمراميه.
وأما أبو فراس بن حمدان، ففارس هذا الميدان؛ إن شئت ضرباً وطعناً، أو
لفظاً ومعنى؛ ملك زماناً، وملك أواناً. وكان أشعر الناس في المملكة،
وأشعرهم في ذل الملكة. وله الفخريات التي لا تعارض، والأسريات التي تناقض.
وأما المتنبي فقد شغلت به الألسن، وسهرت في أشعاره العيون الأعين؛ وكثر
الناسخ لشعره، والآخذ لذكره، والغائص في بحره؛ والمفتش في قعره، عن جمانه
ودره؛ وقد طال في الخلف، وكثر عنه الكشف. وله شيعة تغلو في مدحة، وعليه
خوارج تتعايا في جرحه. والذي أقول: إن له حسنات وسيئات، وحسناته أكثر
عدداً، وأقوى مدداً؛ وغرائبه طائرة، وأمثاله سائرة؛ وعلمه فسيح، وميزه
صحيح؛ يروم فيقدر، ويدري ما يورد ويصدر.
قال أبو الريان: هذا ما عندي من شعراء المشرق، وقد سميت لي من متأخري
شعراء المغرب من لعمري لا يبعد عن معاصرهم، ولا يقصر عن سابقهم.
فأما ابن عبد ربه القرطبي، وإن بعدت عنك دياره، فقد صاقبتنا أشعاره. وقفنا
على أشعار صبوته الأنيقة، وتكفيرات توبته الصدوقة؛ ومدائحه المروانية،
ومطاعنه في العباسية. وهو في كل ذلك فارس ممارس، وطاعن مداعس؛ واطلعنا في
شعره على علم واسع، ومادة فهم مضيء ناصع؛ ومن تلك الجواهر نظم عقده، وتركه
لمن يتجمل به بعده.
وأما ابن هانيء محمد الأندلسي ولادةً، القيرواني وفادةً وإفادة؛
فرعدي الكلام، سردي النظام؛ متين المباني، غير مكين المثاني؛ تجفو بعطنها
عن الأوهام، حتى تكون كنقطة النظام؛ إلا أنه إذا ظهرت معانيه، في جزالة
مبانيه؛ رمى عن منجنيق؛ إلا أنه إذا ظهرت معانيه، في جزالة مبانيه؛ رمى عن
منجنيق، يؤثر في النيق؛ وله غزلٌ قفري، لا عذري؛ لا يقنع فيه بالطيف، ولا
يشفع فيه بغير السيف؛ وقد نوه به ملك الزاب، وعظم شأنه بأجزل الثواب؛ وكان
سيف دولته في إعلاء منزلته؛ من رجل يستعين على صلاح دنياه، بفساد أخراه،
لرداءة عقله، ورقة دينه، وضعف يقينه. ولو عقل لم تضق عليه معاني الشعر،
حتى يستعين عليها بالكفر.
وأما القسطلي فشاعرٌ ماهر؛ عالمٌ بما يقول، تشهد له العقول، بأنه المؤخر
بالعصر، المقدم في الشعر؛ حاذق بوضع الكلام في مواضعه؛ لا سيما إذا ذكر ما
أصابه في الفتنة، وشكا ما داهاه في أيام المحنة. وبالجملة فهو أشعر أهل
مغربه، في أبعد الزمان وأقربه.
وأما علي التونسي فشعره المورد العذب، ولفظه اللؤلؤ الرطب، وهو بحتري
الغرب؛ يصف الحمام، فيروق الأنام، ويشبب، فيعشق ويحبب؛ ويمدح، فيمنح أكثر
ما يمنح.
هذا ما عندي في المتقدمين والمتأخرين، على احتقار المعاصر، واستصغار
المجارر، فحاش الله من الأوصاف، بقلة الإنصاف؛ للبعيد والقريب، والعدو
والحبيب.
قلت: يا أبا الريان، أكثر الله مثلك في الإخوان، ووقاك محذور الزمان،
ومرور الحدثان؛ فلقد سبكت فهما، وحشيت علما.
قال محمد: قلت لأبي الريان في مجلس، عقيب هذا المجلس: يا أبا الريان، لقد
رأيت لك نقداً مصيباً، ومرمى عجيباً، ولقد أرغب في أن أنال منه نصيباً.
قال: النقد هبة الموالد وفيه زيادة طارف إلى تالد؛ ولقد رايت علماء بالشعر
ورواة له ليس لهم نفاذ في نقده، ولا جودة فهم في ردية وجيدة؛ وكثير ممن لا
علم له يفطن إلى غوامضه، وإلى مستقيمه ومتناقضه.
قلت: أنا شديد الرغبة إلى فضلك، في أن تفهمني من ميزك وعقلك؛ ما أستهدي
بسراجه، على مستقيم منهاجه؛ فأقف من سرائره على بعض ما وقفت، وأعرف من
مفاخره ومعانيه جزءً مما عرفت.
قال: نعم: أول ما عليه تعتمد؛ وإياه تعتقد، أن لبا تستعجل باستحسان ولا
باستقباح، ولا باستيراد ولا باستملاح، حتى تنعم النظر، وتستخدم الفكر.
وأعلم أن العجلة في كل شيء موطيء زلوق، ومركب زهوق؛ فإن من الشعر ما يملأ
لفظه المسامع، ويرد على السامع منه فقاقع؛ فلا يرعك شماخة مبناه، وانظر
إلى ما في سكناه من معناه؛ فإن كان في البيت ساكن، فتلك المحاسن؛ وإن كان
خالياً، فأعدده جسماً بالياً. وكذلك إذا سمعت ألفاظاً مستعملة، وكلمات
مبتذلة، فلا تعجل باستضعافها، حتى ترى ما في أضعافها؛ فكم من معنى عجيب،
في لفظ غريب، والمعاني هي الأرواح، والألفاظ هي الأشباح؛ فإن حسنا فذلك
الحظ الممدوح، وإن قبح أحدهما فلا يكن الروح.
قال: وتحفظ عن شيئين: أحدهما أن يحملك إجلال القديم المذكور على العجلة
باستحسان ما تستمع له؛ والثاني أن يحملك إصغارك المعاصِر المشهود على
التهاون بما أنشدت له؛ فإن ذلك جورٌ في الأحكام، وظلم مع الحكام؛ حتى تمحص
قولهما، فحينئذ تحكم لهما أو عليهما. وهذا باب في اغتلافه استصعاب، وفي
صرف العامة وبعض الخاصة عنه إتعاب. وقد وصف تعالى في كتابه الصادق تشبث
القلوب بسيرة القديم، ونفارها من المحدث الجديد، فقال حاكياً لقولهم: )إنا
وجدنا آباءنا على أمةٍ(. وقال: )لن نعبد إلا ما وجدنا عليه آباءنا(. وقد
قلت أنت:
أُغْرِي الناسُ بامتداح القديمِ ... وبذمِّ الجديدِ غَير ذَميمِ
ليس إلا لأنهم حَسَدوا الحيّ ورَقْوا على العِظام الرَّميم وقلتَ في هذا
المعنى:
قُل لمن لا يَرى المُعاصر شَيئاً ... ويرى للأوائل التقديما
إنَّ ذاك القديمَ كان جديداً ... وسَيغدو هذا الجديدُ قديمَا
فلا يرعك أن تجرى على منهاج الحق، في جميع الخَلق؛ فيه قامت السمواتُ
والأرض، وبه أُحكم الإبرام والنقض، وسأمثل لك في ذلك مثالاً، وأملأ أسماعك
مقالاً، وفهمك عدلاً واعتدالا:
هذا أمرؤ القيس، أقدم الشعراء عصراً، ومقدمهم شعراً وذكراً؛ وقد
اتسعت الأقوال في فضله، اتساعاً لم يفز غيره؛ حتى إن العامة تظن بل توقن
أن جواد شعره لا يكبو، وحسام نظمه لا ينبو؛ وهيهات من البشر الكمال، ومن
الآدميين الاستواء والاستدلال؛ يقول في قصيدته المقدمة، ومعلقته المفخمة:
ويومَ دخلتُ الخِدْرَ خِدْر عُنيزةٍ ... فقالت لك الويلاتُ إنك مُرْجِلي
فما كان أغناه عن الإقرار بهذا، وما أشك غفلته عما أدركه من الوصمة به
وذلك أن فيه أعداداً كثيرة النقص والبخس؛ منها دخوله متطفلاً على من كره
دخوله عليه، ومنها قول عنيزة له )لك الويلات(؛ وهي قولة لا تقال إلا
لخسيس، ولا يقابل بها رئيس. فإن احتاج محتاج بأنها كانت أرأس منه. قيل له:
لم يكن ذلك، لأن الرئيسة لا تركب بعيراً يدرج أو )يموت( إذا ازداد عليه
ركوب راكب، بل هو بعير فقير حقير. فإن احتج له بأنه صبر على القول من أجل
أنها معشوقة، قيل له وكيف يكون عاشقاً لها من يقول لها:
فمثلك حُبلى قد طَرقتُ ومُرْضِعاً ... فألهيتُها عن ذي تمائم مُحْول
وإنما المعروف للعاشق الانفراد بمعشوقته واطراح سواها، كالقيسين في ليلى
ولبنى، وغيلان بمية، وجميل بثينة، وسواهم كثير. فلم يكن لها عاشقاً، بل
كان فاسقاً. ثم أهجن هجنة عليه، وأسخن سخنةٍ لعينيه، إقراره بإتيان الحبلى
والمرضع؛ فأما الحبلى فقد جبل الله النفوس على الزهد في إتيانها، والإعراض
عن شأنها؛ منها أن الحبل علّة وأشبه العلل بالاستسقاء، ومع الحبل كمود
اللون، وسوء الغذاء، وفساد النكهة، وسوء الخلق، وغير ذلك. ولا يميل إلى
هذا من له نفس سوقي، دع نفس ملوكي. وأعجب من هذا أن البهائم كلها لا تنظر
إلى ذوات الحمل من أجناسها، ولا تقرب منها حتى تضع أحمالها، أو تفارق
فصلانها. ثم لم يكفه أن يذكر الحبلى حتى افتخر بالمرضع، وفيها من التلويث
بأوضار رضيعها، ومن اهتزالها واشتغالها عن أحكام اغتسالها. وقد أخبر أن ذا
التمائم المحول متعلقٌ بها بقوله )فألهيتها عن ذي تمائم محول(، وأخبر أنها
ظئر ولدها، لا ظئر له ولا مرضع سواها، فدل بذلك على أنها حقيرة وقيرة،
ومثل هذه لا يصبو إليها من له همة. وهذه الصفات كلها تستقذرها نفس الصعلوك
والمملوك.
وقد قال أيضاً في موضع آخر من هذا الباب من قصيدة أخرى:
سموتُ إليها بعد ما نام أهلُها ... سُمُوّ حَباب الماءِ حالاً على حال
فقالتْ لَحَاك اللهُ إنّك فاضِحي ... ألستَ تَرَى السُّمارَ والناسَ أحوالي
حَلَفْتُ لها بالله حِلْفةَ فاجرِ ... لَنامُوا فما إن من حديث ولا صالي
فأخبر هاهنا أنه هين القدر عند النساء وعند نفسه برضاه قولها )لحاك الله(.
فحصل على )لحاك الله( من هذه و)لك الويلات( من تلك. فشهد على نفسه أنه
مكروه ومطرود، غير مرغوب في مواصلته، ولا محروص على معاشرته، ولا مرضي
بمشاكلته. ثم أخبر عن نفسه أنه رضي بالحنث والفجور، وهذه أخلاق لا خلاق
لها. ثم أقر في مكان آخر من شعره بما يكتمه الأحرار، ولا ينم بفتح إلا
الأوضاع الأشرار، فقال:
ولما دنوتُ تَسَدّيتُها ... فثَوْباً نسيتُ وثوباً أجُرّ
وأي فخر في الإقرار بالفضيحة على نفسه وعلى حبه وأين هذا من قول أبي يعقوب
الخزيمي:
ولا أسألُ الولدانَ عن وَجْهِ جارتي ... بعيداً ولا أرْعاه وهو قريبُ
وإنما سهل عليه كل هذا حرصه على ما كان ممنوعاً منه، وذلك أنه كان مبغضاً
إلى النساء جداً، مفروكاً ممن ملك عصبتها لأسباب كثيرة ذكرت. وكل من حرص
على نيل شيء فمنع منه فعلاً، ادعاه قولاً. وله أشباه فيما أتاه، يدعون ما
ادعاه؛ إفكاً وزوراً، وكذباً وفجوراً. منهم الفرزدق، وهو القائل:
هما دلَّياني من ثمانين قامةً ... كما انقضَّ بازٍ أقتمُ الريش كاسرُه
فهذا أول كذبة، ولو قال: )من ثلاثين قامة( لكان كاذباً، لتقاصر الأرشية عن
ذلك. وقد قرعه جرير هذا في قوله:
تدلَّيتَ تَزْني من ثمانين قامةً ... وقَصّرْتَ عن باعِ العُلى والمَكارم
وكان مغرماً بالزنا مدعياً فيه، وقد بلي بموانع تصدفه عنه، منها
ما شهر به من النميمة بمن ساعده، والادعاء على من باعده؛ ومنها دمامته،
ومنها اشتهاره، والمشهور يصل إلى شهوة يتبعها ريبة، فكان يكثر في شعره من
ادعاء الزنا، واستدعاء النساء؛ وهن أغلظ عليه من كبد بعير، وأبغض فيه
وأهجى له من جرير. وخذ أطرف هؤلاء الأجناس، وهو سحيم عبد بني الحسحاس؛
أسيود في شملة، دنسة قملة؛ لا يواكله الغرثان، ولا يصاليه الصرد العريان،
وهو مع ذلك يقول:
وأقبلن مِنْ أقصى البُيوت يَعِدْنني ... نواهدَ لا يَعْرِفن خلقاً سوائياً
يَعِدْن مريضاً هنَّ هَيَّجن ما به ... ألا إنما بعضُ العوائد دائياً
تُوَسِّدني كفّاً وتحنو بمِعْصَم ... عليَّ وتَرْمي رجلَها مِن ورائياً
فأنت تسمع هذا الأسود الشن وادعاءه، وتعلم أن الله لو أخلى الأرض، فلم
يُبق رجلاً في الطول ولا في العرض؛ لم يكن هذا الزنمة الزلمة عند أدراك
السودان إلا كبعرة بعير، في مغر عير؛ والممنوع من الشيء حريص عليه، مدعٍ
فيه؛ والمعتد بما يهواه، كاتم له مستغن ببلوغ مناه؛ ودليل على ذلك أن
المرقش الأكبر كان من أجمل الرجال، وكانت للنساء فيه رغبة، وشدة محبة؛
وكان كثير الاجتماع بهن، والوصول إليهن؛ وله في ذلك أخبارٌ مروية، ولم يكن
في أشعاره صفة شيء من ذلك. فحسبك بذلك صحة على ما قلناه.
فإن قال قائل: إنما وصفت عن امرئ القيس عيوباً من خلقه لا في شعره، قلنا:
هل أراد بما وصف في شعره إلا الفخر؟ فإن قال: لم يرد ذلك وإنما أراد إظهار
عيبه. قلنا: فأحمق الناس إذاً هو، ولم يكن كذلك. وإن قال: نعم، الفخر.
قلنا: فقد نطق شعره بقدر ما أراد، وترجم عنه قريضه بأقبح الأوصاف. فأي خلل
من خلال الشعر أشد من الانعكاس والتناقض. وكل ما يخزي من الشعر فهو أشد
عيوبه.
قال: ومن كلام امريء القيس المخلخل الأركان الضعيف الاستكمان، المتزلزل
البنيان، قوله:
أَمَرْخٌ خيامُهُمُ أم عُشَرْ ... أم القلبُ في إثْرِهم مُنْحَدِرْ
وشاقذ بين الخليط الشُطُرْ ... وممن أقام من الحيّ هِرّ
وهرٌّ تَصِيد قلوبُ الرجالِ ... وأفلَتَ منها ابنُ عمرو حُجُرْ
فأنت تسمع هذا الكلام الذي لا يتناسب، ولا يتواصل ولا يتقارب، ولا يحصل
منه معنى ولا فائدة، سوى أن السامع يدري أنه يذكر فرقة من أحباب، لكن ذلك
عن ترجمة معجمة، مضطربة منقلبة. سأل عن الخيام: أمرخٌ هي أم عشر؟ وليست
الخيام مرخاً ولا عشراً، وإنما هما عودان. فإن أراد في مكان هذين الخيام،
فقد نقض عمدة الكلام، لأن مرخه وعشره أتي بها نكرتين فأشكل بذلك. وإنما
يجوز لو جعلهما معرفة بالألف واللام، والوزن لا يساعده على ذلك، ثم قال:
أم القلب في إثرهم مُنحدر وليس هذا السؤال من السؤال الأول في شيء إلا من
بعد بعيد، واحتيال شديد. وقال بعد هذا:
وشاقذ بين الخليط الشطر ... وممن أقام من الحي هِرّ
فأتى بكثير كلام لا يفيد إلا قليل معنى. وذلك القليل لا غريب ولا عجيب،
وهو كله ذكر فراق. ثم رجع إلى أن )هِرّ( فقيمةٌ تصيد قلبه وقلب غيره،
فأبطل بإقامتها كل ما قال من أخبار الفراق ونقضه، وجعل بكاءه المتقدم لغير
شيء. ثم قال: وأفلت منها ابن عمرو حجر فحسن عنده أن يخبر أن الناس قد صادت
هر قلوب جميعهم إلا قلب حجر أبيه. وهذا من الأحاديث الركيكة، والأخبار
التي ما بأحد حاجة إليها. ومع هذا فقد أورد أصحاب الأخبار أن )هر( هذه
كانت زوجة أبيه حجر، فانظر ما في جملة هذه الأبيات من الركاكات، وقلة
الإفادات؛ فإنها لا تفيد قلامة، ولا تهز ثمامة. ولسنا ننكر بهذه العيوب
ونزارتها، ما أقررنا له به من الفضائل وندارتها؛ وستجد من لا يصدق معاصرا،
ولا يصدق على متقادم متأخرا؛ يبنى على ضعف أسه، ويفديه من الجهل والعيب
بنفسه. فإذا اعترضك من هذا النمط متعرض، فأعرض عنه ودعه على أخلاقه،
مستمتعاً بخلاقه، واتبع المسلك الذي أوضحته لك.
قال أبو الريان: وفضلاء الشعراء كثير ولكلٍ سقطات، وسأقفك على بعضها لعظيم
المؤونة في الإحاطة بها ليس إلا، لأوضح بذكرها منهجاً من مناهج النقد، لا
حرصاً على بعض الفصحاء، ولا قصداً إلى تهجين الصرحاء، وأية رغبة لنا في
ذلك وهم جرثومة فروعنا، وبهم أفتخار جميعنا.
قال: زهير بن ابي سلمى على ما وصفناه به ووصفه غيرنا، من العلو
والرفعة، في هذه الصنعة، من مذهبته الحكمية، ومعلقته العلمية:
رأيت المَنايا يا خَبط عَشواءَ من تُصِب ... تُمتْه ومن تُخطئْ يُعمَّر
فيهرم
وقد غلط في وصفها بخبط العشواء، على أننا لا نطالبه بحكم ديننا، لأنه لم
يكن على شرعنا، بل نطلبه بحكم العقل فنقول: إنما يصح قوله لو كان بعض
الناس يموت وبعضهم ينجو، وقد علم هو وعلم العالم، حتى البهائم، ان سهام
المنايا لا تخطيء شيءاً من الحيوان حتى يعمها رشقها، فكيف يوصف بخبط
العشواء رام لا يقصد غرضا من الحيوان إلا أقصده حتى يستكمل رمياته، في
جميع رمياته. وإنما أدخل الوهم على زهير موت قوم عبطة وموت قوم هرماً،
وظنوا طول العمر إنما سببه إخطاء المنية، وسبب قصره إصابتها. وهيهات
الصواب من ظنه لم يؤخر الهرم إلا أنها قصدته فحين قصدته أصابته. ولو أن
الرماة تهتدي كاهتدائها، لملأت أيديها بأقصى رجائها.
وقال زهير أيضاً في مذهبته:
ومَن لا يَذُدْ عن حَوضه بسلاحه ... يُهَدَّم ومن لا يَظلم الناسَ يُظلَم
وقد تجاوز هذا الحق الباطل، وبني قولاً لا ينقصه جريان العادة، وشهادة
المشاهدة؛ وذلك أن الظلم وعرة مراكبه، مذمومةٌ عواقبه، في جاهليته
وإسلامنا. فحرض في شعره عليه، وإن كان إنما أشار في شعره إلى أن الظالم
يرهب فلا يظلم، فهذا قياس ينفسد، واصل ليس يطرد، لكن يرهبه من هو أضعف
منه، وربما انتقم منه بالحيلة والمكيدة. وقد يظلم الظالم من يغلبه فيكون
ذلك سبب هلاكه مع قباحة السمة بالظلم. والمثل إنما يضرب بما لا ينخرم، وقد
كانت له مندوحة واتساع في أن يقول: )يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم( فهذا
أصح وأسلم من من لا يظلم ويظلم.
قال أبو الريان: وقال زهير أيضاً، وهو من أطيب شعره وأملحه عند العامة،
وكثير من الخاصة، فهاهنا تحفظ وتأمل، ولا يهلك ذلك منهم، الحق أبلج. قال:
تراه إذا ما جئتَه مُتَهلّلا ... كأَنك تُعطيه الذي أنت سائلُه
مدح بها شريفاً أي شريف، فجعل سروره بقاصده كسروره بمن يدفع شيءاً من عرض
الدنيا إليه. وليس من صفات النفوس العارفة السامية، والهمم الشريفة
العالية، إظهار السرور إلى أن تهلل وجوههم وتسر نفوسهم بهبة الواهب، ولا
شدة الابتهاج بعطية المعطي، بل ذلك عندهم سقوط همة وصغر نفس. وكثير من ذوي
النفوس النفيسة، والأخلاق الرئيسية، لا يظهر السرور متى رزق مالاً عفواً
بلا منة منيل، ولا يد معطٍ مستطيل؛ لأنه عند نفسه أكبر منه، ولأن قدر
المال يقصر عنه؛ فكيف يمدح ملك كبير كثير القدر، عظيم الفخر، بأنه يتهلل
وجهه ويمتلئ سروراً قلبه، إذا أعطى سائله مالاً. هذا نقض البناء، ومحض
الهجاء، والفضلاء يفخرون بضدٍّ هذا، قال بعضهم:
ولستُ بِمِفراح إذا الدهرُ سرَّني ... ولا جَزع من صَرفه المتقلّب
وإنما غرَّ زهيراً وغرَّ المُستحسن بيته هذا ما جبلوا عليه من حب العطاء،
وما جرت به عاداتهم من الرغبة في الهبات والاستجداء؛ وليس كل الهمم تستحسن
ذلك، ولا كل الطباع تسلك هذا المسالك.
قال أبو الريان: وقال زهير أيضاً يمدح سادةً من الناس فذمهم بأنواع الذم،
وأكثر الناس على استحسان ما قال، بل أظن كلهم على ذلك، وهو قوله:
على مُكثِريهم حقُّ من يَعْتريهمُ ... وعند المقلّين السماحةُ والبذْل
فأول ما ذمَّهم به إخباره أن فيهم مُكثرين ومُقلّين. فلو كان مُكثروهم
كرماء لبذلوا لمقليهم الأموال، حتى يستووا في الحال، ويشبهوا في الكرم
والحال، الذين قال فيهم حسان:
المُلحقين فقيرَهم بغنيِّهم ... والمُشفقين على اليتيم المُرْمل
المُرْمِلُ: القليل المال، وأرمل الرجل: إذا قل زاده. وكما قال غيره:
الخالطينَ فقيرَهم بغنيِّهم؟ ... حتى يعود فقيرُهم كالكافي
وكما قالت الخرنق:
الخالطينَ لُجينَهم بنُضارهم ... وذوي الغِنى منهم بذي الفَقْر
وكما قالت الخرنق:
الخالطينَ لُجينَهم بنُضارهم ... وذوي الغِنى منهم بذي الفَقْر
فهذا كله، وأبيك، غاية المدح، النقي من القدح. ثم استمع ما في هذا البيت
سوى هذا من الخلل والزلل. قال:
على مُكثريهم حقُّ مَن يعتريهمُ ... وعند المُقلِّين السماحةُ والبذْلُ
ففي هذا القسم الأول عيوبٌ على المكثرين منهم، منها أنهم ضيعوا
القريب كما قدمنا، ورعوا حق الغريب، وصلة الرحم أولى ما بديء به. ومن
مكارم العرب حميتها لذوي أنسابها، وذبها عن أحسابها؛ والأقرب فالأقرب، وما
فضل عن ذلك فللأبعد. ثم أخبر أن المكثيرين ليس يسمحون بأكثر من الاستحقاق
في قوله: على مُكثريهم حقُّ من يعتريهمُ ومن أعطى الحق فإنما أنصف ولم
يتفضل بما وراء الإنصاف، والزيادة على الإنصاف أمدح. ثم أخبر في البيت أن
المقلين على قدر قصور أيديهم أكرم طباعاً من مكثريهم على قدرهم في قوله:
وعند المقلين السماحةُ والبذْل والبذْل مع الإقلال مدح عظيم وإيثار،
والسماحة أعطاء غير اللازم، فمدح بشعره هذا من لا يحظى منه بطائل، وذم
الذين يرجو منهم جزيل النائل؛ وهذا غاية الغلط في الاختيار، وفي ترتيب
الأشعار. ولزهير غير هذا من السقطات لولا كلفة الاسقتصاء. هذا على اشتهاره
بأنه أمدح الشعراء، وأجزل الوافدين على الأشراف والأمراء؛ وسيتعامى
المتعصب له عن وضوح هذا البيان، وسينكر جميع هذا البرهان؛ ويجعل التفتيش
عن غوامض الخطأ والصواب استقصاء وظلماً، ومطالبة وهضما، وزعم أن جميع
الشعر لو طلب هذه المطالبة لبطل صحيحه، وانعجم فصيحه، والباطل الذي زعم،
والمحال الذي به تكلم؛ فالسليم سليم، والكليم كليم، وإنما سمع المسكين أن
أملح الشعر ما قلت عباراته، وفهمت إشاراته؛ ولمحت لمحه، وملحت ملحه؛ ورققت
حقائقه، وحققت رقائقه؛ واستغني فيه بلمحه الدالة، عن الدلائل المتطاولة؛
وأمثال هذا الكلام، في استعمال النظام. فتوهم أن خلل الشعر وزلله وضعف
أركانه، وتناقض بنيانه، وانقلاب لفظه لغو، وانعكاس مدحه عجو؛ إذا خلا مما
قدمنا من الأوصاف المستحسنة، من لمح إشاراته، وملح عباراته، فعامل هذا
الصنف، بعطفك عنهم للعطف، ورفعك عليهم الأنف، وأعرض عنهم بالفكر والذكر،
كبراً وإن لم تكن من أهل الكبر.
وفيما أطلعتك عليه من شعر هذين الفحلين، والمتقدمين القديمين، ما يغني عن
التفتيش على سقطات سواهما، فقس على ما لم تره بما ترى، واعلم أن كل الصيد
في جوف الفرا.
قال أبو الريان: ومن عيوب الشعر اللحن الذي لا تسعه فسحة العربية، كقول
الفرزدق:
وعَضّ زمانٌ يابن مروان لم يَدَعْ ... من المال إلا مُسحتاً أو مجلفُ
فرفع )مجلفاً( وحقه النصب. وقد تحيل له بعض النحويين بكلام كالضريع، لا
يسمن ولا يغني من جوع، وكقول جرير بن الخطفى:
ولو ولدتْ فُقيرةُ جروَ كَلبٍ ... لسُبّ بذلك الجرو الكلابَا
فنصب )الكلاب( بغير ناصب. وقد تحيّل أيضاً بعض النحويين على وجهٍ، الإقفاء
أحسن منه، فاحذر هذا ومثله. وإياك وما يعتذر منه بفسيح من العذر، فكيف
بضيق ضنك.
قال: ومما يعاب به الشعر، ويستهجنه النقد، خشونة حروف الكلمة، كقول جرير:
وتقولُ بَوزَعُ قد دببتَ على العصا ... هلاً هزِئْتِ بغيرنا يا بَوْزَعُ
وهذا البيت في قصيدة من أحلى قصائد جرير وأملحها، وأجزلها وأفصحها، فثقلت
القصيدة كلها بهذه اللفظة.
وللفرزدق أيضاً لفظات خشنة الحروف كهذه تجدها في شعره. قال: ويكره النقاد
تعقيد الكلام في الشعر وتقديم آخره وتأخير أوله، كقول الفرزدق:
؟وما مثله في الناس إلاّ مملّكاً ... أبو أمه حيّ أبوه يُناسبه
يمدح به إبراهيم بن هشام المخزومي، وهو خال هشام بن عبد الملك. فمعنى هذا
الكلام أن إبراهيم بن هشام ما مثله في الناس حي إلا مملك. يعني هشاماً أبا
أمه، أي جد هشام لأمه أبو إبراهيم هذا الممدوح، فهو خاله أخو أمه، فهو
يشبهه في الناس لا غير، وهذا غاية التعقيد والتنكيد، وليس تحته شيء سوى
أنه شريف كابن أخته شريف.
قال أبو الريان: ومن شر عيوب الشعر كلها الكسر، لأنه يخرجه عن نعته شعراً،
وليس مما يقع لمن نعت بشاعر. فأما الإقواء، والإبطاء، والسناد، والإكفاء،
والزحاف، وصرف ما لا ينصرف، فكل ذلك يستعمل، إلا أن السالم من جميع ذلك
أجمل وأفضل.
قال: ومن عيوبه المذمومة مجاورة الكلمة ما لا يناسبها ولا يقاربها، مثل ول
الكميت: حتى تكامل فيها الدلُّ والشَّنبْ وكما قال بعض المتأخرين في رثاء:
فإنّك غُيّبتَ في حُفرة ... تراكم فيها نعيمٌ وحورُ
وإن كان النعيم والحور من مواهب أهل الجنة، فليس بينهما في
النفوس تقارب. ولا لفظة )تراكم( مما يجمع بين )الحور( ولا )النعيم(.
ومثله قول بعضهم:
والله لولا أنيقال تغيّرَا ... وصبا وإنْ كان التصابي أجدرَا
لأعاد تُفَّاح الخدود بَنفسجاً ... لثمي وكافورَ الترائب عنبرَا
فالتفاح ليس من جنس البنفسج، لأن التفاح ثمرة والبنفسج زهرة. وقد أجاد في
جمعه بين الكافور والعنبر، لأنهما من قبيل واحد. ولو قال:
لأعاد ورد الوَجنتين بنفسجاً ... لَثْمي وكافورَ الترائب عنبرَا
لأجاد الوصف، وأحسن الرصف، لكون الورد من قبيل البنفسج. فهذا النوع
فافتقد، وهذا الشرع فاعتمد.
قال أبو الريان: ولفضلاء المولدين سقطات مختلفات في أشعارهم، أذاكرك منها
في أشياء، لتستدل بها على أغراضك، لا لطلب الزلات، ولا لاقتفاء العثرات:
كان بشار تتباين طبقات شعره، فيصعد ]صغيرها[ كبيرها، ويهبط قليلها كثيرها.
وكذلك كان حبيب بن أوس الطائي. فإذا سمعت جيدهما، كذبت أن رديهما لهما؛
وإذا صح عندك أن ذلك الردي لهما، أقسمت أن جيدهما لغيرهما.
قال: ومما يعاب من الشعر الافتتاحات الثقيلة. مثل قول حبيب أول قصيدة:
هُنَّ عوادي يوسفٍ وصواحبُه ... فعزماً فَقدْماً أدرك الشأوَطالبُه
ومثل قول ديك الجنّ أولَ قصيدة:
كأَنها يا كأنه خللَ الخلّة ... وقف الهلوك إذْ بغَمَا
فابتدأ هو وحبيب بُمضمرات على غير مظهرات قبلها، وهو رديء.
قال: ويعاب أيضاً الافتتحات المتطير بها، والكلام المضاد للغرض، كابتداء
قصيدة أبي نواس التي أنشدها الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي يهنئه ببنيانه
الدار الجديدة، فدخل إليه عند كمالها وقد جلس للهناء والدعاء، وعنده وجوه
الناس، فأنشده:
أرَبعَ البِلى إنَّ الخُشوع لبادِي ... عليك وإنّي لم أَخُنك ودادي
فتطير الفضلُ من ذلك ونكس رأسه، وتناظر الناس بعضهم إلى بعض، ثم تمادى
فختم الشعر بقوله:
سلامٌ على الدُّنيا إذا ما فُقدتُم ... بنى بَرمك مِن رائحين وغادِي
فكمل جهله، وتم خطؤه؛ وزاد القلوب المتوقعة للخطوب سرعة توقع، واضاف
للنفوس المتوجعة بذكر الموت شدة توجع؛ وأراد أن يمدح فهجا، ودخل ليسر فشجا.
قال: وقريب من هذا ما وقع للمتنبي في أول شعر أنشده كافورا:
كفى بكَ داءً أن ترى الموتَ شافياً ... وحسبُ المنايا أن يكنَّ أمانيَا
فهذا خطاب بالكاف بفتح ولا سيما في أول لقيه، وفي ابتداء واستعطاف ورقية.
وفي هذا البيت غير هذا من العيوب سنذكره بعد.
ووق مثل هذا من قبح الاستفتاح في عصرنا، وذلك أن بعض الشعراء أنشد بعض
الأمراء في يوم المهرجان فقال:
لا تَقُل بُشْرَى ولكن بُشْرَيَان ... وجهُ من أهوى ووجه المِهْرَجان
فأمر بإخراجه، واستطار بافتتاحه، وحَرمه إحسانه.
قال أبو الريّان: ولو كان هذا الشاعر حاذقاً لكان إصلاح هذا الفساد أيسر
الأشياء عليه، وذلك بأن يعكس البيت فيقول:
وجه من أهوى ووجه المِهرجان ... أي بُشرى هي لا بل بُشريان
قال: ويقبح جداً الإتيان بكلمة القافية معجمة لا ترتبط بما قبلها من
الكلام، وإنما هي مفردة لحشو القافية، كقول بعضهم:
فَبُلّغْتَ المنى برغم أعادي ... ك وأبقالك سالماً ربُّ هود
فأنت ترى غثاثة هذه القافية، والله تعالى رب جميع الخلق وكل شيء، فخص
هوداً عليه السلام وحده لضعف نقده وعجزه عن الإتيان بقافية تليق وتحسن.
قال: ويقبح أيضا الجفاء في النسب على الحبيب والتضجر ببعده، وغلظة العتاب
على صده، كقول أبي نواس:
أجارة بيتينا أبوك غَيورُ ... ومَيْسورُ ما يُرجى لديك عَسيرُ
فإن كنتِ لا خلاّ ولا أنت زوجةٌ ... فلا بَرحت منّا عليك سُتور
وجاورتِ قوماً لا تَزَاورَ بينهم ... ولا قُربَ إلا أن يكون نُشور
فلم أسمع بأوحش من هذا النسيب، ولا أخشن من هذا التشبيب، وذلك
قوله: إن لم تكوني لي زوجة ولا صديقة فلا برحت منا ستور للتراب عليك، ولا
كان جارك ما عشنا نحن إلا الموتى الذين لا يتزاورون ولا يتواصلون إلى يوم
النشور. على أن كلامه يشهد عليه بأنه شاك، وإنما المعروف في أهل الرقة
والظرف، والمعهود من أهل الوفاء والعطف؛ أن يفدوا أحبابهم بالنفوس، من كل
مكروه وبوس؛ فأين ذهبت ولادته البصرية، وآدابه البغدادية؛ حتى اختار الغدر
على الوفاء، وبلغت به طباعه إلى أجفى الجفاء؟ فاعلم هذا وإياك أن تعمل به.
قال: ومن عيوب الشعر السرق. وهو كثير الأجناس، في شعر الناس. فمنها سرقة
ألفاظ، ومنها سرقة معان؛ وسرقة المعاني أكثر لأنها أخفى من الألفاظ. ومنها
سرقة المعنى كله، ومنها سرقة البعض، ومنها مسروق باختصار في اللفظ وزيادة
في المعنى، وهو أحسن المسروقات، ومنها مسروق بزيادة ألفاظ وقصور عن
المعنى، وهو أقبحها؛ ومنها سرقة محضة بلا زيادة ولا نقص. والفضل في ذلك
للمسروق منه ولا شيء للسارق، كسرقة أبي نواس في هذه القصيدة التي ذكرنا
معنى أبي الشيص بكماله. قال أبو الشيص:
وقف الهوى بي حيثُ أنت فليس لي ... متأخّر عنه ولا مُتقدّمُ
فسرقه الحسن بكماله فقال:
فما حازه جودٌ ولا حلّ دونه ... ولكن يصير الجودُ حيث يصيرُ
فهذا هذا، على أن بيت أبي الشيص أحلى وأطبع، ومع حلاوته جزالة. وقد ذكر عن
الحسن أنه قال: ما زلت أحسد أبا الشيص على هذا البيت حتى أخذته منه. وسرقة
المعاصر سقوط همة. وبهذه القصيدة يناضل أصحاب الحسن عنه ويخاصمون خصماءه
مقرين بأن ليس له افضل منها، ولا لهم إلى سوى القصيدة معدل عنها. فقس
بفهمك، وأعمل فكرك، على ما وصفناه من أبواب السرق ما وجدته في أشعار لم
أذكرها، يظهر لك جميع ما وصفناه، ويبدو لك جمي ما رسمناه.
قال: ومما يقع في عيوب الشعرن ويغفل الشاعر عنه، ويجوزه الأمر فيه، لصغر
جرم العيب، وسلامة اللفظ الذي احتبى فيه، ثم يكون ذلك سبب غفلة النقاد
أيضاً عنه مثل قول المتنبي: كفى بك داءَ أن ترى الموت شافيا فضع هذا
الكلام على أنه إنما شكا داءه ووصفه بالعظم فعاد شاكياً نفسه، وجعلها أعظم
الداء، لأنه أراد كفى بدائك داءً فغلط، وقال: كفى بك داءً. فصار: كفى
بالسلامة داء. فالسلامة هي الداء. يريد: طول البقاء سبب للفناء. وقال الله
تعالى: )وكفى بنا حاسبين( فالله هو أعظم شهيد: فجعل المتنبي نفسه أعظم
الداء، ولم يرد إلا استعظام دائه. وإصلاح هذا الفساد، وبلوغه إلى المراد،
أن يقول:
كَفى بالمنايا أن تكن أمانيَا ... وحسبُك داءَ أن ترى الموتَ شافيَا
فيعود الداء المستعظم كما أراد، وتزول خشونة ابتدائه، وشدة جفائه، إذ خاطب
الممدوح بالكاف فجعله داء عظيما في أول كلمة سمعها منه.
وقد تأدب خواص الناس وكثير من عوامهم في مثل هذا المكان، فهم يقولون عند
مخاطبات بعضهم بعضاً بما يخشن ذكره: قلت للأبعد، ويا كذا أو كذا للأبعد.
ومن عيوب هذا القسم أيضاً أن قائله قصد إلى سلطان جديد، وإلى
مكان يحتاج فيه إلى التعظيم والتفخيم، وقد صدر عن ملك نوه به، أعني سيف
الدولة، وأغناه بعد فقره، وشرفه ورفعه، وأدنى موضعه. فورد على كافور هذا
في مرتبة شريفة، وخطة منيفة؛ فجعل بجهله يصفه في أول بيت لقيه به أنه في
حالة لا يرى منها المنية، أو يرى المنية أعظم أمنية. وعلم كافور بذكائه
ووصول أخبار الناس إليه أنه في حالةٍ خلاف ما قال، وأنه كفر النعمة من
المنعم عليه، وأراه أن جميع ما عامله به من الجاه الواسع، والغنى القاطع،
حقير لديه، صغير في عينيه. فعلم كافور في هذا الوقت أنه ممن لا تزكو لديه
الصنيعة وإن عظمت، ولا تكبر في عينيه المواهب وإن جسمت؛ ولم يكن في خلق
كافور من الصبر على اتساع البذل، ولا من الرغبة في أهل الآداب والفضل، ما
عند سيف الدولة من ذلك، فزهد فيه بعد رغبة، وعلله بالقليل، وشاوقه
بالجزيل. ورأى المتنبي أن الأسود ليس له في قلبه من الحب والقرى ما له عند
سيف الدولة، فلم يدل عليه، ولا كثر من التعتب والعتاب ما يعطفه عليه؛
فأضاع وضاع، وكان يتوقع الإيقاع؛ ولكفران النعم نقم، ثم نجاه ركوب ظهر
الهرب، وأقبل يعترف لسيف الدولة بالذنوب. وكان لحنه وشعره شريفين، وعقله
ودينه ضعيفين. ومع ذلك فسقطاته كثيرة إلا أن محاسنه أكثر وأوفر، والمرء
يعجز لا محالة. وكان يمل إلى تعقيد الكلام، ويعتمد على علمه بقبحه، فيقول
من ذلك ما يصف به ناقته:
فتبيت تُسئد مُسئداً في نيّها ... إسآدها في المَهمه الأنضاء
يقول في المدح:
أنّي يكون ابا البريّة آدم ... وأبوك والثّقلان أنت محمد
ويقول في بيت آخر من قصيدة آخرى يمدح بها، والبيت لا يتعلق بشيء مما قبله
فيما يظهر ولا فيما بعده بشيء:
كأنك ما جاودتَ من بان جودُه ... عليك ولا قاومتَ من لم تُقاوم
ومثل هذا كثير، وهذه الأجناس من أبيات وإن ظهرت معانيها بعد استقصاء،
وأطاعت غوامضها بعد استعصاء؛ فهي مذمومة السلك، وإن اطلعت منها على أجزل
الإفادة، فكيف إذا حصلت منها على السلامة بلا زيادة. وكان أيضاً يغفل عن
إصلاح أشياء من كلامه على قرب ذلك الإصلاح من الفهم، مثل قوله يرثي أخت
سيف الدولة:
يا أخت خيرِ أخٍ يا بنتَ خير أبٍ ... كنايةً بهما عن أشرف النسبِ
فجعل )يا أخت خير( و)بنت خير( كناية عن أشرف النسب، والكناية لا تكون إلا
لعلل تتسع فيها التهم، لأن الكناية ستر وتعمية، فما بال شرف النسب يورى
عند تورية المعايب، ويكنى عنه والتصريح به من المفاخر والمناقب. وقد غفل
عن إصلاح هذا بلفظ فصيح، ومعنى صحيح؛ قد كاد يبرز من الجنان، إلى طرف
اللسان، وهو لو فطن إليه:
يا أختَ خير أخٍ يا بنتَ خير أب ... غنى بهذا وذا عن أشرف النسب
قال أبو الريّان: وهذه الجملة التي أثبت لك فيها ما دخل على الشعراء
المجيدين من التقصير والغفلة والغلط وغير ذلك، كافية ومغنية عن إيراد سوى
ذلك؛ وإن لقيتها بجودة بحث وصحة قياس، ولم تحتج إلى كشف عيوب أشعار الناس.
ولعل قائلاً يقول: مال على هؤلاء وترك سواهم لميله على من بكت، ولتفضيله
من عنه سكت. فقل لمن قال ذلك الأمر: على خلاف ما ظننت لم أذكر إلا الأفضل
فالأفضل، والأشهر فالأشهر، إذ كانت أشعارهم هي المروية، فالحجة بهم وعليهم
هي القوية؛ فقد نقلته على من ميلى عليهم، إلى ميلى الحق إليهم.
قال أبو الريان: فأما نقد المستحسن فتمثيله لك يعظم ويتسع لكثرته، فلا
يسعنا ايراده ولكن ما سلم من جميع ما أوردناه فهو في حيز السالم، ثم تتسع
طبقات الجودة فيه، وأحسن منه ما اعتدل مبناه، وأغرب معناه، وزاد في
محمودات الشعر على سواه، ثم يمدح الأدون فالأدون، بمقدار انحطاطه إلى حيز
السلامة، ثم لا مدح ولا كرامة.
قال محمد: فقلت: لله درك يا أبا الريان، فما ألين جانبك، وما أقرب غائبك،
وما ألحح طالبك، وما أسعد صاحبك. فقال. أنجح الله مطالبك، وقضى مآربك،
وصفى من القذى مشاربك، وبث في الحواضر والبوادي مناقبك.
تمت المقامة المعروفة بمسائل الانتقاد بلطف الفهم والاقتصاد.
والحمد لله أولاً وآخراً، وصلاته على نبيه سيدنا محمد وآله وسلامه.