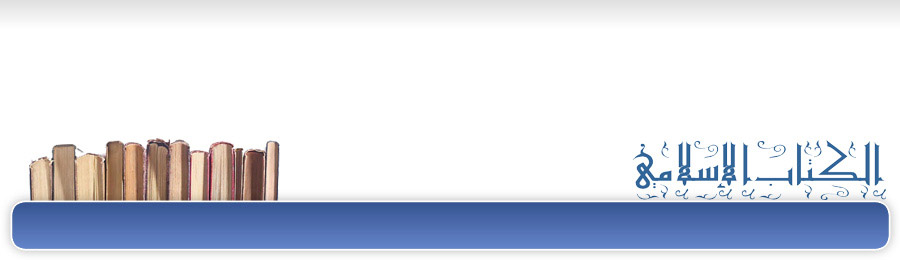كتاب : ذكرى العاقل وتنبيه الغافل
المؤلف : عبد القادر الجزائري
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما
ًيقول عبد القادر، بن محيي الدين، بن المصطفى، بن محمد، ابن المختار، بن عبد القادر، بن أحمد، بن عبد القادر، بن أحمد، ابن محمد، بن عبد القوي، بن علي، بن أحمد، بن عبد القوي ابن خالد، بن يوسف، بن أحمد، بن بشار، بن أحمد، بن محمد، ابن مسعود، بن طاوس، بن يعقوب، بن عبد القوي، بن أحمد، ابن محمد بن إدريس، بن عبد الله الكامل، بن الحسن المثنى، بن الحسن سبط الرسول، بن علي، بن أبي طالب، بن عبد المطلب، بن هاشم.
وأم الحسن، فاطمة، بنت محمد، رسول الله، بن عبد الله، ابن عبد المطلب، هاشم.
الحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن العالمين.
أمّا بعد؛ فإنه بلغني: أن علماء باريز وفقهم العليم الحكيم العزيز، كتبوا اسمي في دفتر العلماء. ونظموني في سلك العظماء. فاهتززت لذلك فرحاً ثم اغتممت ترحاً، فرحت من حيث ستر الله علي، حتى نظر عباده، بحسن الظن إليّ. واهتممت من كون العلماء، استسمنوا ذا ورم ونفخوا في غير ضرم، ثم أشار علي بعض المحبين منهم؛ بإرسال بعض الرسائل إليهم. فكتبت هذه العجالة للتشبه بالعلماء الأعلام. ورميت سهمي بين السهام.
فتشبهوا إن لم تكونوا منهم ... أن التشبه بالكرام رباح
وسميت هذه الرسالة ذكرى العاقل وتنبه الغافل ووتبتها على مقدمة، وثلاثة أبواب وخاتمة. وفي كل باب: فصل، وتنبيه، وخاتمة.
أما المقدمة، ففي الحث على النظر، وذم التقليد.
وأما الباب الأول، ففي فضل العلم والعلماء، وفيه فصل: في تعريف العقل، الذي به إدراك العلوم وتكملة في القوى الأربع، التي إذا اعتدلت في الإنسان، يكون إنساناً كاملاً. وتنبيه في: فضل إدراك العقل، على إدراك الحواس، وفضل مدركات العقل، على مدركات الحواس، وخاتمة في: انقسام العلم، إلى محمود ومذموم.
وأما الباب الثاني: ففي العلم الشرعي، وفيه فصل في: إثبات النبوة، التي هي منبع العلوم الشرعية، وفيه تنبيه في: معرفة النبي، وما يتعلق بالنبوة، وخاتمة في المكذبين للأنبياء وأما الباب الثالث: ففي فضل الكتابة. وفيه فصل في: الكلام على كتابات الأمم، ومن وضعها وما ينجر إلى ذلك.
وتنبيه في: بيان حروف الكتابة العربية، وخاتمة في: احتياج الناس إلى التصنيف وما يتعلق به.
الباب الأول
تقديم في العلم والجهل
اعلموا: أنه يلزم العاقل، أن ينظر في القول، ولا ينظر إلى قائله. فإن كان القول حقاً، قبله، سواء كان قائله معروفاً بالحق، أو الباطل، فإن الذهب يستخرج من التراب. والنرجس، من البصل، والترياق، من الحيات ويجتنى الورد، من الشوك فالعاقل: يعرف الرجال بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال. والكلمة من الحكمة، ضالة العاقل يأخذها من عند كل من وجدها عنده، سواء كان حقيراً، أو جليلاً. وأقل درجات العالم، أن يتميز عن العامي بأمور، منها: أنه لا يعاف العسل، إذا وجده في محجمة الحجام و يعرف أن الدم قذر، لا لكونه في المحجمة ولكنه قذر في ذاته، فإذا عدمت هذه الصفة في العسل، فكونه في ظرف الدم المستقذر، لا يكسبه تلك الصفة، ولا يوجب نفره عنه. وهذا وهم باطل، غالب على أكثر الناس. فمهما نسب كلام إلى قائل، حسن اعتقادهم فيه، قبلوه. وإن كان القول باطلاً. وإن نسب القول، إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه.وإن كان حقاً ودائماً يعرفون الحق بالرجال. ولا يعرفون الرجال بالحق. وهذا غاية الجهل والخسران. فالمحتاج إلى الترياق إذا هربت نفسه منه، حيث علم أنه مستخرج من حية، جاهل. فيلزم تنبيهه. على أن نفرته، جهل محض. وهو سبب حرمانه من الفائدة، التي هي مطلوبة. فإن العالم، هو الذي يسهل عليه إدراك الفرق، بين الصدق والكذب، في الأقوال. وبين الحق والباطل، في الاعتقادات، وبين الجميل والقبيح في الأفعال. لا بأن يكون ملتبساً عليه الحق بالباطل والكذب بالصدق، والجميل بالقبيح. ويصير يتبع غيره، ويقلده فيما يعتقد وفيما يقول. فإن هذه ما هي إلا صفات الجهال.
والمتبوعين من الناس، على قسمين: قسم عالم مسعد لنفسه، ومسعد
لغيره، وهو الذي عرف الحق بالدليل، لا بالتقليد، ودعا الناس إلى معرفة
الحق بالدليل، لا بأن يقلدون. وقسم مهلك لنفسه، ومهلك لغيره، وهو الذي قلد
آباءه وأجداده، فيما يعتقدون، ويستحسنون، وترك النظر بعقله، ودعا الناس
لتقليده.
والأعمى لا يصلح أن يقود العميان. وإذا كان تقليد الرجال مذموماً، غير
مرضي في الاعتقادات، فتقليد الكتب، أولى وأحرى بالذم، وأن بهيمة تقاد،
أفضل من مقلد ينقاد، وإن أقوال العلماء والمتدينين، متضادة، متخالفة في
الأكثر، واختيار واحد منها، واتباعه بلا دليل، باطل لأنه ترجيح بلا مرجح،
فيكون معارضاً بمثله.
وكل إنسان، من حيث هو إنسان، فهو مستعد لإدراك الحقائق، على ما هي عليه،
لأن القلب، الذي هو محل العلم، بالإضافة إلى حقائق الأشياء، كالمرآة
بالإضافة إلى صور المتلونات، تظهر فيها كلها على التعاقب. لكن المرآة، قد
لا تنكشف فيها الصور، لأسباب، أحدها: نقصان صورتها، كجوهر الحديد، قبل أن
يدور ويشكل ويصقل، والثاني لخبثه وصدئه، وإن كان تام الشكل والثالث لكونه
غير مقابل للجهة، التي فيها الصورة، كما إذا كانت الصورة وراء المرآة.
والرابع لحجاب مرسل بين المرآة والصورة، والخامس للجهل بالجهة التي فيها
الصورة المطلوبة حتى يتعذر بسببه أن يحاذي به الصورة وجهتها.
فكذلك القلب، مرآة مستعدة، لأن ينجلي فيها صور المعلومات كلها، وإنما خلت
القلوب عن العلوم، التي خلت عنها لهذه الأسباب الخمسة. أولها: نقصان في
ذات القلب، كقلب الصبي، فإنه لا تنجلي له المعلومات لنقصانه، والثاني
لكدرات الأشغال الدنياوية، والخبث الذي يتراكم على وجه القلب منها،
فالإقبال على طلب كشف حقائق الأشياء والإعراض عن الأشياء الشاغلة القاطعة،
هو الذي يجلو القلب، ويصفيه، والثالث: أن يكون معدولاً به عن جهة الحقيقة
المطلوبة والرابع الحجاب، فإن العقل المتجرد للفكر، في حقيقة من الحقائق،
ربما لا تنكشف له، لكونه محجوباً باعتقاد، سبق إلى القلب، وقت الصبا، طريق
التقليد، والقبول بحسن الظن، فإن ذلك يحول بين القلب، والوصول إلى الحق،
ويمنع أن ينكشف في القلب، غير ما تلقاه بالتقليد، وهذا حجاب عظيم، حجب
أكثر الخلق، عن الوصول إلى الحق لأنهم محجوبون باعتقادات تقليديه، وسخت في
نفوسهم، وجمدت عليها قلوبهم والخامس؛ الجهل بالجهة التي يقع فيها العثور
على المطلوب.
فإن الطالب لشيء، يمكنه أن يحصله، إلا بالتذكر للعلوم.
التي تناسب مطلوبه حتى إذا تذكرها، ورتبها في نفسه ترتيباً مخصوصاً، يعرفه
العلماء، فعند ذلك، يكون قد صادف جهة المطلوب فتظهر حقيقة المطلوب لقلبه،
فإن العلوم المطلوبة، التي ليست فطرية، لا تصاد إلا بشبكة العلوم الحاصلة.
بل كل علم لا يحصل إلا عن علمين سابقين، يأتلفان، ويزدوجان، على وجه
مخصوص، فيحصل، من ازدواجهما، علم ثالث على مثال حصول النتاج، من ازدواج
الفحل والأنثى، ثم كما أن من أراد أن يستنتج فرساً، لم يمكنه ذلك من حمار
وبعير، بل من أصل مخصوص، من الخيل، الذكر والأنثى، وذلك إذا وقع بينهما
ازدواج مخصوص، فكذلك كل علم فله أصلان مخصوصان، وبينهما طريق مخصوص في
الازدواج، يحصل من ازدواجهما، العلم المطلوب فالجهل بتلك الأصول وبكيفية
الازدواج، هو المانع من العلم ومثاله: ما ذكرناه، من الجهل بالجهة، التي
الصورة فيها بل مثاله:أن يريد الإنسان أن يرى قفاه مثلا بالمرآة، فإنه إذا
رفع المرآة قبالة وجهه، لم يكن حاذى بها جهة القفا، فلا يظهر فيها القفا،
وإن رفعها وراء القفا وحاذاه كان قد عدل بالمرآة عن عينيه، فلا يرى
المرآة، ولا صورة القفا فيها فيحتاج إلى مرآة أخرى، ينصبها وراء القفا،
وهذه المرآة، في مقابلتها، بحيث يراها، ويراعي مناسبة بين وضع المرآتين،
حتى تنطبع صورة القفا، في المرآة المحاذية للقفا، ثم تنطبع صورة هذه
المرآة، مع ما فيها من صورة القفا، في المرآة الأخرى التي في مقابلة
العين، ثم تدرك العين صورة القفا.
فكذلك في اصطياد العلوم، وطلب إدراك الأشياء، طرق عجيبة، فيها انحرافات عن المطلوب أعجب مما ذكرناه في المرآة، فهذه هي الأسباب المانعة للقلوب، من معرفة الحقائق، وإلا فكل قلب، فهو بالفطرة الإلهية، صالح لإدراك الحقائق، وكما أن الشيء، يكون حاضراً بين يدي الإنسان، وإذا لم يحرك حدقته، من جانب إلى جانب، تحريكات كثيرة لم ير ذلك الشيء، فكذلك العقل وكما أن العين الباصرة، لا يمكنها إدراك العقل لا يقدر على إدراك الحقائق، دون خطأ، إلا إذا طلعت عليه أنوار التوفيق والهداية من الله تعالى.
فصل العلم والعلماء
اعلموا: أن الإنسان، من حيث حصوله، في الحيز والمكان، فجسم كسائر الأجسام، ومن حيث يتغذى وينسل فنبات، ومن حيث يحس، ويتحرك بالاختيار، فحيوان ومن حيث صورته وقامته، فكالصورة المنقوشة على الحائط. وكما أن الفرس، يشارك الحمار في قوة الحمل ويختص عنه بخاصية الكر والفر وحسن الهيئة، فيكون الفرس مخلوقاً لأجل تلك الخاصية. فإن تعطلت منه، نزل إلى مرتبة الحمار، فكذلك الإنسان، يشارك الجمادات والحيوانات في أمور، ويفارقها في أمور، هي خاصيته، وبها شرفه، فما حصل له الشرف بعظم شخصه، فإن الفيل أعظم منه، ولا بشجاعته، فإن الأسد أشجع منه، ولا لأكله، فإن الجمل أوسع منه بطناً، ولا لجماعه، فإن أخس العصافير أقوى منه جماعاً، وإنما شرف الإنسان وخاصيته التي يتميز بها عن جميع الموجودات، هي العلم،و بها كماله. إذا كمال كل شيء، إنما يكون بظهور خاصيته التي امتاز بها عن غيره ونقصانه هو خفاء تلك الخاصية، فبقدر ظهور تلك الخاصية. يطلق عليه اسم الكامل، وبحسب سترها فيه، يخص باسم الناقص مثلاً الخاصية، التي امتاز بها الفرس، وهي الحقيقة الفرسية، أن يكون شديد العدو، ومعتدل القوائم في الطول والقصر، مدركاً لإشارة الراكب من: إرادة الكر، والفر، أو الهملجة، أو الحضر أو التقريب، فإذا ظهرت هذه الخاصية: قيل: فرس كامل. ثم الإعزاز والإهانة تابعان للكمال والنقصان. وخاصية الإنسان، هي معرفة حقائق الأشياء، على الوجه الذي هي عليه، بحيث يرتفع عن بصيرته حجاب الشك. ويتيقن حقائقها، مكتشفة له. وبكمال هذه الخاصية ونقصانها، يفضل بعض أفراد الإنسان بعضاً، إلى أن يعد واحد بألف.ولم أر أمثال الرجال تفاوتت ... إلى المجد، حتى عد ألف بواحد
والناس ألف منهم كواحد ... وواحد كالألف إن أمر عنا
ولا شيء أقبح من الإنسان، مع ما فضله الله به، من القدرة، على تحصيل الكمال بالعلم، أن يهمل نفسه، ويعريها من هذه الفضيلة.
ولم أر في عيوب الناس شيئاً ... كنقص القادرين على الكمال
ولما كان العلم، هو كمال الإنسان، كان كل إنسان، محباً للعلم بالطبع، ويشتهيه ويفرح إذا نسب إلى العلم، ولو قليلاً، ولو يعلم أن الذي وصفه بالعلم، كاذب. ويحزن إذا دفع عن ربتة العلم، ويلتذ الإنسان بالعلم، لذاته ولكماله، لا لمعنى آخر، وراء الكمال. ولا يخفى على أهل العلم: أنه لا لذة فوق لذته، لأنها لذة روحانية، وهي اللذة الخالصة من جميع الشوائب المكدرات. وأما اللذة الجسمانية، فهي، عند التحقيق، دفع ألم. إذ لذة الأكل دفع ألم الجوع ولذة الجماع، دفع ألم امتلاء أوعية المني به، بخلاف اللذة الروحانية، فإنها ألذ وأشهى ولهذا كان بعض العلماء يقول، عند ما تنحل له مشكلات العلوم: أين الملوك، وأبناء الملوك، من هذه اللذة ومن المعلوم أن اللذات، بالإضافة إلى الإنسان، من حيث اختصاصه بها، ومشاركته لغيره، ثلاثة أنواع، عقلية وجسمانية مشتركة مع بعض الحيوانات، وجسمانية مشتركة مع جميع الحيوانات.
أما العقلية: فالعلم بحقائق الأشياء، إذ ليس يستلذ بها السمع
والبصر والشم والذوق ولا البطن، وإنما يستلذ بها القلب لاختصاصه بصفة،
يعبر عنها بالعقل، وهذه اللذة، أقل اللذات وجوداً، وهي أشرف اللذات. أما
قلتها، فلأن العلم لا يستلذ به إلا عالم. وما أقل أهل العلم والحكمة، وما
أكثر المتسمين باسمهم، والمرتسمين برسمهم. وأما شرفها، فلأنها لازمة لا
تزول أبداً، لا في الدنيا، ولا في الآخرة، ولا تمل والطعام يشبع منه فيمل
وشهوة النكاح، يفرغ منها، فتستثقل والعلم والحكمة، لا يتصور قط أن تمل
وتستثقل والمال يسرق أو يحرق، والولاية يعزل عنها والعلم لا تمتد إليه
أيدي السراق بالأخذ، ولا أيدي السلاطين بالعزل، فيكون صاحبه في روح الأمن
أبداً، وأما قصور أكثر الخلق، عن إدراك لذة العلم، فلفساد أمزجتهم، ومرض
قلوبهم، لاشتغالهم باتباع الشهوات، واستيلائها على عقولهم فإن القلب، إذا
كان صحيحاً لا يستلذ إلا بالعلم، فإذا كان مريضاً بسوء العادات استلذ
بغيره، كما يستلذ بعض الناس أكل الطين وكالمريض الذي لا يدرك حلاوة العسل
ويراه مراً
ومن يك ذا فم مر مريض ... يجد مراً به الماء الزلالا
وإما لقصور فطنتهم، إذ لم تخلق لهم الصفة، التي بها يستلذ العلم كالطفل
الرضيع الذي لا يدرك لذة الطيور السمان، ولا لذة العسل، ولا يطلب إلا
اللبن.
الثانية: لذة يشارك الإنسان فيها بعض الحيوانات، كلذة الرياسة والغلبة
والاستيلاء... وذلك موجود في الأسد، والنمر، وبعض الحيوانات.
الثالثة: لذة يشارك الإنسان فيها جميع الحيوانات، كلذة البطن والفرج، وهذه
أكثر اللذات وجوداً وهي أخسها، ولذلك اشترك فيها كل ما دب وتحرك، حتى
الديدان والحشرات.
ولأجل اللذة، والكمال الذي في العلم. صار للإنسان ميل طبيعي إلى العلم،
غالباً، لكن من الناس من ساعده فهمه ومنهم من لم يساعده. وأما عدم الميل
إلى العلم، فلأمر عارض كفساد الطبع، أو بعد المكان عن الاعتدال. والمقصود
من هذا معرفة فضيلة العلم ونفاسته، وما لم تفهم الفضيلة في نفسها، لم يكمن
أن يعلم وجودها، صفة للعلم، أو لغيره من الخصال فلقد غلط من طمع أن يعلم،
أن فلاناً حكيم، وهو لم يعرف معنى الحكمة وحقيقتها، فالفضيلة، مأخوذة من
الفضل، وهو الزيادة، فإذا تشارك شيئان في صفة، واختص أحدهما بمزيد يقال:
فضله، وله الفضل عليه، مهما كانت زيادة فيما هو كمال ذلك الشيء، كما يقال:
إن الفرس، أفضل من الحمار بمعنى أنه يشاركه في قوة الحمل ويزيد عليه بقوة
الكر و الفر وشدة العدو، وحسن الصورة، فلو فرض حمار اختص بسلعة زائدة على
ظهره لم يقل: إنه أفضل لأن السلعة زيادة في الجسم، ونقصان في المعنى وليست
من الكمال. والحيوان، مطلوب لمعناه، وصفاته لا لجسمه، فإذا فهمتم هذا لم
يخف عليكم: أن العلم فضيلة، إن أخذتموه بالإضافة إلى جميع الحيوانات. أو
أخذتموه بغير إضافة فإنه فضيلة وكمال، على الإطلاق، وبه شرف العلماء
والحكماء، وهو المرغوب فيه، المطلوب لذاته، لا لغيره.
وغير خاف عليكم، أن الشيء المرغوب فيه، ينقسم إلى ما يطلب ويرغب فيه
لغيره. وإلى ما يطلب ويرغب فيه لذاته، وإلى ما يطلب ويرغب فيه لذاته
ولغيره جميعاً والذي يطلب لذاته، أشرف وأفضل والمطلوب لغيره، الدراهم
والدنانير فإنهما حجران، لا منفعة لهما، ولولا أن الله، سهل قضاء الحوائج
بهما. لكانا والحجر بمنزلة واحدة لأنهما لا يدفعان جوعاً، ولا برداً، ولا
حراً، بأنفسهما.
وأما الذي يطلب لذاته، فالعلم. فإنه لذيذ في ذاته، وأما الذي يطلب لذاته
ولغيره، فكسلامة البدن، فإن سلامة الرجل، مثلاً، مطلوبة، من حيث أنها
سلامة البدن عن الألم، ومطلوبة للمشي بها، والتوصل إلى الحاجات. ومن دلائل
شرف العلم ولوازمه. احترام العالم. في الطباع، حتى إن أغبياء الناس
وأجلافهم. يصادفون طباعهم. مجبولة على توقير شيوخهم. لاختصاصهم بعلم زائد،
مستفاد من التجارب. والبهائم بطباعها توقر الإنسان لشعورها بتميز الإنسان.
بكمال مجاوز لدرجاتها.
وإذا ثبت فضيلة العلم. كان تعلمه أفضل. وبيانه: أن مقاصد الخلق. مجموعة في
انتظام الدين والدنيا. ولا نظام للدين. إلا بانتظام الدنيا. وليس ينتظم
أمر الدنيا. إلا بأعمال الآدميين. وأعمالهم وصناعاتهم وحرفهم. تنحصر في
ثلاثة أقسام.
أحدها: أصول لأقوام للدنيا إلا بها. وهي أربعة: الزراعة وهي
للمطعم. والحياكة. وهي للملبس. والبناء. وهو للمسكن والسياسة. وهي للتألف
والاجتماع والتعاون على أسباب أمر المعيشة.
القسم الثاني: ما هي مهيأة لكل واحد من هذه الصناعات وخادمة لها. كالحدادة
فإنها تخدم الزراعة. وجملة من الصناعات بإعداد آلاتها. وكالحلاجة والغزل،
فإنها تخدم الحياكة بإعداد عملها.
القسم الثالث: ما هي متممة للأصول كالطحن والخبز للزراعة، وكالقصارة
والخياطة للحياكة. وذلك بالإضافة إلى قوام أمر العالم الأرضي مثل أجزاء
الشخص، بالإضافة إلى جملته، فإنها ثلاثة أقسام: إما أصول كالقلب والكبد
والدماغ وإما خادمة لها كالمعدة والعروق والشرايين والأعصاب والأوردة.
وإما مكملة لها ومزينة. كالأظفار والحاجبين، وأشرف الصناعات، أصولها
السياسة ولذلك تستدعي هذه الصناعة من الكمال في من يتكفل بها. مالا تطلبه
سائر الصناعات. فلذلك يستخدم صاحب هذه الصناعة جميع أصحاب الصناعات.
والسياسة. على مرتبتين: سياسة الملوك والسلاطين، وتصرفهم في الخاصة
والعامة، ولكن في ظواهرهم فقط لا فقط في بواطنهم والثانية: سياسة العلماء
وتصرفهم في بواطن الخاصة، ولا تنتهي قوتهم، إلى التصرف في ظواهرهم،
بالإلزام والقهر.
وشرف العلوم والصناعات يدرك بثلاثة أمور: إما بالالتفات إلى الآلة، التي
يتوصل بها إلى معرفتها، كفضل العلوم العقلية على العلوم اللغوية، إذا تدرك
الحكمة بالعقل واللغة بالسمع. والعقل أشرف من السمع. وإما بالنظر إلى عموم
النفع، كفضل الزراعة إلى الصياغة وإما بالنظر إلى المحل، الذي فيه التصرف
كفضل الصياغة على الدباغة، إذا محل أحدهما الذهب ومحل الآخر جلد الحيوانات
الميتة،وغير خاف: أن العالم متصرف في قلوب الناس المتعلمين، ويدرك شرف
العلم، مطلقاً، من حيث هو علم، بشيئين، أحدهما شرف الثمرة والثاني قوة
الدليل، وذلك كملم الأحكام الدينية الشرعية، وعلم الطب، فإن ثمرة علم
الدين، السلامة في الدار الآخرة وهي الحياة الأبدية. وثمرة الطب السلامة
في الدنيا، وهي سلامة بدنية منقطعة. فيكون علم الدين أشرف، لأنه سبب
لسلامة أبدية لا تنقطع، الثاني، كعلم الحساب، وعلم النجم، فإن علم الحساب،
أشرف لوثاقة أدلته وقوتها وإذا نسب الحساب إلى الطب، كان الطب أشرف،
باعتبار ثمرته، والحساب أشرف باعتبار قوة أدلته وصحتها، وملاحظة الثمرة
الأولى ولذلك كان الطب أشرف وإن كان أكثر الطب بالظن.
تعريف العقل
اعلموا: إن العقل منبع العلم، وأساسه ومطلعه، والعلم، يجري من العقل، مجرى الثمر من الشجر، والنور من الشمس والرؤية من العين. وكيف يخفى فضل العقل وأعظم البهائم بدناً وأشدهم ضراوة، وأقواهم سطوة إذا رأى صورة الإنسان هابه لشعوره بفضله عليه، واستيلائه، بسبب ما خص به من إدراك الحيل.واسم العقل يطلق على أربع معان، بالاشتراك.
الأول: الوصف، الذي يفارق الإنسان به جميع البهائم، وهو الذي استعد به الإنسان لقبول العلوم النظرية الثاني: هي العلوم: التي تخرج إلى الوجود، في ذات الطفل المميز، بجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات، كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد،وأن لا يكون الشخص الواحد، لا يكون في مكانين، في آن واحد، وتسمية هذه العلوم عقلاً، ظاهر فلا تنكر.
الثالث: علوم تستفاد من التجارب بمجارى الأحوال، فإن من جرب الأمور، وهذبه تخالف الأحوال، يقال: إنه عاقل في العادة، ومن لا يتصف به، يقال: إنه غبي جاهل وهذا نوع آخر من العلم، يسمى عقلا، الرابع: أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف الإنسان عواقب الأمور، ويقمع الشهوة، الداعية إلى تناول اللذة المضرة، ويقهرها فإذا حصلت هذه القوة ويسمي صاحبها عاقلاً من حيث أن إقدامه وتأخره يحسب ما يقتضيه النظر في العواقب.
وهذه المعاني الأربعة كلها، من خواص الإنسان ولفظ العقل موضوع في
الحقيقة. لتلك الغريزة، وإطلاقه على العلوم مجاز، من حيث أنها ثمرتها،
وهذه العلوم كأنها متضمنة في تلك الغريزة بالخلقة، ولا تظهر إلى الوجود،
إلا إذا جرى سبب يخرجها حتى كأن هذه العلوم ليست بشيء وارد عليها من خارج،
وكأنها كانت مستكنة فيها، فظهرت، ومثاله: الماء في الأرض فإنه يظهر
بالحفر، ويجتمع، ويتميز بالحس، لا بأن يساق إليه شيء جديد، وكذلك، الدهن
في اللوز، وماء الورد في الورد فكل أدمي، خلق مجبولاً على معرفة الأشياء
على ما هي عليه أعني: أنها كالمتضمنة فيه، لقرب استعداده للإدراك.
ثم لما كانت معرفة الأشياء مركوزة في النفوس بالخلقة انقسم الناس إلى: من
أعرض نفسي وهم الجهال وإلى من أجال خاطره فتذكر وهم العلماء، فكان هذا
القسم، كمن حمل شهادة، فنسيها بسبب الغفلة، ثم تذكرها، وحصول هذه العلوم
للإنسان لها درجتان.
إحداهما: أن يشتمل قلبه على العلوم الضرورية الظاهرة، فتكون العلوم
النظرية فيه، غير حاصلة، إلا أنها صارت قريبة الحصول، ويكون حاله بال: من
أعرض نفسي وهم الجهال وإلى من أجال خاطره فتذكر وهم العلماء، فكان هذا
القسم، كمن حمل شهادة، فنسيها بسبب الغفلة، ثم تذكرها، وحصول هذه العلوم
للإنسان لها درجتان.
إحداهما: أن يشتمل قلبه على العلوم الضرورية الظاهرة، فتكون العلوم
النظرية فيه، غير حاصلة، إلا أنها صارت قريبة الحصول، ويكون حاله بالإضافة
إلى العلوم، كحال الكاتب، الذي لا يعرف من الكتابة إلا الدواة والقلم
والحروف المفردة، دون المركبة فإنه قد قارب الكتابة ولم يبلغها.
الثانية: أن تحصل له العلوم المكتسبة، بالتجارب والفكر فتكون كالمخزونة
عنده فإذا شاء رجع إليها، وحاله حال الحاذق بالكتابة، إذ يقال له: كاتب
وأن لم يكن مباشر للكتابة لقدرته عليها، وفي هذه الدرجة، مراتب لا تحصى
يتفاوت العلماء فيها، بقلة المعلومات وكثرتها، وشرف المعلومات وخستها.
واعلموا: أن العقول: متفاوتة بحسب خلقة الله تعالى، التي خلق الناس عليها،
فعقول الأنبياء ليست كعقول سائر الناس. وعقل أبي علي بن سينا، فائق على
كثير من العقول. يحكى، أن الرازي قال يوماً للآمدي: لم حسن إهلاك
الحيوانات وذبحها للإنسان فقال له الآمدي: إهلاك المفضول لمصلحة الفاضل هو
عين العدل فقال له الرازي إذاً، يحسن ذبحك أنت لأبي علي بن سينا.
والتفاوت. حاصل في الأقسام التي يطلق عليها أسم العقل، إلا العلم
بالضروريات فإنه لا يحصل فيه تفاوت بين العقلاء وكل من يدركه يدرك إدراكاً
محققاً، من غير شك.
وأما قسم علم التجارب. فتفاوت الناس فيه. لا ينكر فإنهم متفاوقون: بكثرة
إصابة الرأي، وسرعة الإدراك ويكون سببه: إما تفاوتاً في الغريزة وإما
تفاوتا في ممارسة الأمور.
وأما قسم استيلاء القوة العقلية على قمع الشهوات، فلا يحفى تفاوت الناس
فيه ويكون سببه، التفاوت في العلم المعروف بضرر تلك الشهوة ولهذا يقرر
الطبيب على الاحتماء عن بعض الأطعمة المضرة وقد لا يقدر على ذلك من يساويه
في العقل إذا لم يكن طبيباً وإن كان يعتقد فيه مضرة على الجملة ولكن لما
كان علم الطبيب أتم كان خوفه أشد فيكون الخوف معيناً للعقل على قمع
الشهوات المضرة.
وأما قمم الغريزة التي قلنا أنه الأصل فالتفاوت فيه لا طريف إلى جحده فإنه
مثل نور يشرق على الإنسان ويطلع صبحه ومبادئ إشراقه عند سن التمييز وهو
تمام الأسبوع الأول أعني سبع سنين ثم لا يزال ينمو ويزداد على التدريج إلى
أن يتكامل يقرب الأربعين سنة ومثاله: نور الصبح فإن أوائله تخفى حفاء بشق
إدراكه ثم يتدرج إلى الزيادة، إلى أن يكمل بطلوع قرص الشمس، وعادة الله
جارية في جميع مخلوقاته، بالتدريج وكيف ينكر تفاوت الناس في الغريزة ولولا
تفاوتها لما اختلف الناس في فهم العلوم.
ولما انقسموا إلى بليد لا يفهم بالتفهيم إلا بعد تعب طويل من
المعلم وإلى ذكي يفهم بأقل إشارة وإلى كامل يدرك حقائق الأشياء دون تعليم
فلقتسام الناس إلى من يتنبه من نفسه ويفهم وإلى من لا يفهم إلا بتنبيه
وتعليم وإلى ما يجمع فيه الماء ويقوي فيتفجر بنفسه عيوناً وإلى ما يحتاج
إلى الحفر ليخرج الماء في الآبار وإلى ما لا ينفع فيه الحفر وهو اليابس
وذلك لاختلاف جواهر الأرض في صفاتها فكذلك هذا الاختلاف في النفوس في
غريزة العقل.
والسبب الظاهر بحسب العادة، أجراها الله باختياره وبما دل عليه الاستقرار
في اختلاف الناس في عقولهم وأخلاقهم وسيرهم أحوال الشمس في الحركة فإن
الناس على ثلاثة أقسام: أحدها: الذين يسكنون تحت خط الاستواء إلى ما يقرب
من المواضع التي يحاذيها ممر رأس السرطان واسمهم العام السودان والأجل أن
الشمس تمر على رؤوسهم إما مرة أو مرتين في السنة صارت أبدانهم وشعورهم
سوداء وهم أضعف الناس عقلاً وأوحشهم أخلاقاً وأما الذين مساكنهم، أقرب إلى
ممر رأس السرطان، فعقولهم أكمل من الذين قبلهم والسواد فيهم أقل وطبائعهم
معتدلة وأخلاقهم مؤنسة وأجسامهم نظيفة وهم أهل الهند، واليمن، وبعض
المغاربة وكل العرب.
وأما القسم الثاني من أهل الأرض فهم الذين مساكنهم على رأس ممر السرطان
إلى محاذاة بنات نعش. وهم سكان وسط هذه المعمورة وهو المسمى بإيران شهر،
كأهل العراق والشام وخراسان وأصبهان فهم أكمل الناس عقلاً وألطفهم أذهاناً
وهم مختلفون في الكمال، ويليهم في الكمال، سكان فرنسا فإنهم وسط الإقليم
الخامس ويليهم في الكمال أهل الأندلس فإن بلادهم أخذت من الإقليم الخامس
والسادس وأما القسم الثالث من سكان الأرض فهم الذين مساكنهم محاذية لبنات
نعش وهم الروس والصقالبة فعقولهم ناقصة وأخلاقهم وحشية وطبائعهم باردة.
ولكثرة بعدهم عن حر الشمس صار البرد عليهم أغلب والرطوبات أكثر لأنه ليس
هنالك ما ينشفها وينضجها. فلذلك صارت ألوانهم بيضاء وشعورهم شقراء سبطة
وأبدانهم عظيمة رخوة.
تكملة القوى الأربع
قوة العقل هي إحدى القوى الأربع التي إذا اعتدلت في الإنسان يكون إنساناً كاملاً وهي قوة العقل وقوة الشجاعة وقوة العفة وقوة العدل.فقوة العقل هي حالة النفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع الأحوال والعدل حالة للنفس بها يسوس الغضب والشهوة ويجملها على مقتضى العقل في الاسترسال والانقباض والشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها والعفة تؤدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع فمن اعتدال هذه القوى الأربع تصدر الأخلاق الجميلة كلها فمن اعتدال قوة العقل يحصل حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأمور ومن إفراطها المذموم، تحصل الصفات المذمومة والأخلاق القبيحة، مثل: المكر والحقد والخداع والدهاء والحيلة ومن تفريط المذموم أيضاً تصدر الصفات المذمومة، مثل البله والغباوة والغمارة والحمق والجنون. وأعني بالغمارة قلة التجربة في الأمور مع سلامة التخيل والجنون عبارة عن اختلال القوة العملية المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة، المدركة للعواقب، بأن لا يظهر أثرها، وتتعطل أفعالها إما بسبب نقصان خلق عليه وإما بسبب خلط أو آفة. والفرق بين الحمق والحنون: أن الأحمق مقصودة صحيح ولكن سلوكه الطريق الموصل إلى الغرض وأما المجنون، فإنه يختار ما لا ينبغي أن يختار فيكون أصل اختياره فاسداً وأما الشجاعة فيصدر عنها الكرم والنجدة والشهاة وكسر النفس، والاحتمال والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتودد إلى الناس وأمثالها وهي صفات محمودة وأما إفراط هذه القوة وهو مذموم فيحصل منه التهور والصلف والبذخ والتكبر والعجب والاستشاطة وأما تفريطها وهو مذموم أيضا فيصدر منه المهانة والمذلة والجزع والحساسة وصغر النفس ولانقباض عن تناول الحق اللازم.
تنبيه العقل المدرك
من الظاهر البين عند أصحاب العقول السليمة أن النفس إنما دخلت
هذا العالم الجسماني لتكتسب العلم النافع والعمل الصالح وأشرف العلوم
النافقة معرفة الله تعالى ومعرفة حكمته في أفعاله وفي خلق السموات والأرض
وما فيهما وما بينهما وهذه المعرفة لا تدرك بحاسة من الحواس وإنما تدرك
بالعقل فكان العقل لهذا أشرف ومدركاته أشرف ولما كان البدن مركباً للنفس
وآلة لتحصيل الأعمال الصالحة خلق الله للإنسان الحواس الظاهرة والباطنة
وأكرمه بالعقل الذي هو أشرف من الكل فخلق له حاسة اللمس حتى إذا مسته نار
محرقة أو سيف جارح أحس بذلك وهرب وهذا أول حس يخلق للحيوان فلو لم يحس
أصلاً لم يكن حيواناً وأقل درجات الإحساس أن يحس بما يلاصقه ويماسه فإن
الإحساس بما يبعد منه، إحساس أتم. وهذا موجود في كل حيوان ولو لم يحلق
للإنسان إلا هذا الحس لكان ناقصاً لا يقدر على طلب الغذاء من حيث يبعد عنه
بل ما يماس بدنه يحس به فيجتذبه إلى نفسه فقط فافتقر إلى حس يدرك ما بعد
عنه فخلق له الشم إلا أنه يدرك به الرائحة ولا يدري من أي جهة جاءت فيحتاج
إلى أن يطوف كثيراً من الجوانب وقد يعثر على الغذاء الذي شم رائحته وقد لا
يعثر فيكون ناقصاً لو لم يحلق له إلا ذاك فخلق له البصر ليدرك به ما بعد
عنه ويدرك جهته، فيقصد تلك الجهة بعينها إلا أنه لو لم يحلق له إلا هذا
لكان ناقصاً إذ لا يدرك ما وراء الجدران والحجب فحلق له السمع حتى يدرك به
الأصوات من وراء الجدران والحجب عند جريان الحركات.
لأنه لا يبصر الأشياء حاضراً وكل هذا ما كان نافعاً له لو لم يكن له حس
الذوق إذا يصل الغذاء إليه فلا يدرك أنه موافق له، أو محالف فيأكله فيهلك
كالشجرة تصيب في أصلها كل مائع ولا ذوق لها فتجذبه وربما يكون ذلك سبب
هلاكها ويبسها وكل هذا لا يكفيه لو لم يحلف في مقدمة دماغه إدراك آخر يسمى
حساً مشتركاً تتأذى إليه هذه المحسوسات وتجتمع فيه فإنه إذا أكل شيئاً
أصفر مثلاًُ فوجده مراً غير موافق له فتركه فإذا رآه مرة أخرى لا يعرف أنه
مضر مر ما لم يذقه ثانياً لولا الحس المشترك لأن العين تبصر الصفرة ولا
تدرك المرارة والذوق يدرك المرارة ولا يدرك الصفرة فلا بد من حاكم تجتمع
عنده الصفرة والمرارة جميعاً حتى إذا رأى الصفرة حكم بأنه مر فيمتنع عن
تناوله ثانياً وهذا كله تشاركه فيه الحيوانات إذ للشاة هذه الحواس فلو لم
يكن له إلا هذا لكان ناقصاً لأن هذه الحواس إنما هي للحاضر فأما الغائب
وإدراك العواقب فلا ولما كان المقصود الأعظم من خلق الإنسان هو معرفة
خالقه وعبادته والعبادة لا تكون لمن لا يعرف أكرم الله الإنسان وميزه بصفة
أخرى أشرف من الكل وهي العقل فبه يفرق الإنسان خالقه ويدرك المنافع
والمضار في الحال والمآل إذ أنفع الحواس وأبعدها مدركاً العين الباصرة
والعقل أشرف منها لأن البصر لا يدرك نفسه ولا يدرك إدراكه ولا يدرك آلته
أما أنه لا يدرك نفسه ولا إدراكه فلأن القوة الباصرة وإدراكها ليسا من
الأمور المبصرة بالعين الباصرة وأما أنه لا يدرك آلته فلأنها هي العين
والقوة الباصرة في العين لا تدرك العين وأما العقل فإنه يدرك نفسه ويدرك
إدراكه ويدرك آلته في الإدراك وهي القلب والدماغ وأيضاً البصر لا يدرك
الكليات والعقل يدركها ومدرك الكليات أشرف من مدرك الجزئيات أما أن البصر
لا يدرك الكليات فلأن التبصر لو أدرك كل ما في الوجود ما فهو أدرك الكل
لأن الكل عبارة عن كل ما يمكن دخوله في الوجود في الماضي والحال
والاستقبال وأما أن العقل يدرك الكليات فلأنا نعرف أن الأشخاص الإنسانية
مشتركة في الإنسانية ومتمايزة بخصوصياتها وما به المشاركة غير ما به
الممايزة فالإنسانية من حيث هي إنسانية مغايرة لهذا المشخصات وأما أن
إدراك الكليات أشرف فلأن إدراك الكليات ممتنع التغير وإدراك الجزئيات واجب
التغير ولأن إدراك الكلي يتضمن إدراك الجزئيات، الوقعة تحته لأن ما ثبت
للماهية يثبت لجميع أفرادها.
وأيضاً الإدراك الحسي غير منتج لأن من أحس بشيء لا يكون ذلك الإحساس سببا لحصول إحساس أخر بل لو استعمل آله الحس مرة لأحس به مرة أخرى وذلك لا يكون إنتاج إحساس لإحساس آخر. وأما أن الإدراك العقلي، ينتج فلأنا إذا عقلنا أموراً، ثم ركبناها في عقلنا توسلنا بتركيبها إلى اكتساب علوم أخر وأيضاً الإدراك الحسي، لا يسع الأمور الكثيرة، والعقل يتسع لها. أما أن الحس لا يتسع لها فلأن البصر، إذا توالى عليه ألوان كثيرة التبست عليه،فأدرك لوناً كأنه حاصل من اختلاط هذه الألوان والسمع إذا توالت عليه أصوات كثيرة التبست عليه ولم يحصل التمييز والعقل يتسع لها. ولأن كل من كان تحصيله للعلوم، أكثر، كانت قدرته على كسب الجديد أسهل لأن مهما حصلت معرفة أخرى وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك نتائج آخر وهكذا يتمادى الإنتاج وتتمادى العلوم لكن هذا لمن يقدر على استثمار العلوم ويهتدي إلى طريق التفكير وإنما منع أكثر الناس من زيادة العلوم لفقدهم رأس المال وهي المعارف التي تستثمر العلوم كالذي لا رأس مال معه فإنه لا يقدر على الربح وقد يملك رأس المال ولكن لا يحسن صناعة التجارة فلا يربح شيئاً فكذلك قد يكون مع الإنسان ما هو رأس العلوم ولكن لا يحسن استعمالها وتأليفها وإيقاع الازدواج المفضي إلى النتاج وأيضاً البصر لا يدرك الشيء المرئي مع غاية القرب مع غاية البعد، والعقل عنده القرب والبعد سواء فإنه يدرك ما فوق السموات، وما تحت الأرض، ويدرك ذات الله تعالى مع كونه مقدساً عن القرب والبعد والجهة وأيضاً الحس قد يقع في إدراكه الغلط كثيراً فإنه يدرك الصغير كبيراً كالنار البعيدة في الظلمة وكالعنبة في الماء ترى كالإجاصة وكالنقطة من النار إذا كانت على رأس عود وحركته باستقامة فإنه يرى خطاً ممدوداً، من نار وإذا حركته على دائرة بسرعة يرى دائرة من نار ولا وجود لهما أصلاً ويرى المعدوم موجوداً كالسراب في الصحراء فإنه يري ماء ويرى المتحرك ساكناً كالظل يراه ساكناً وهو متحرك ويرى الثلج أبيض ولا بياض فيه أصلاً فإنه مركب من أجزاء شفافة لا لون لها وهي الأجزاء المائية الرشية فلو لا العقل لكان معتقد صحة ما أدركه حسه مخطئاً خطأ فاحشاً ولهذا قال أفلاطون وأرسطو وبطليموس وجالينوس: الحسيات غير يقينية بمعنى أن جزم العقل بالحسيات ليس بمجرد الحس، بل لا بد مع الإحساس من أمور تنضم إلى الحس لا تعمل ما هي وحينئذ يجزم العقل بما جزم به من المحسوسات.
وهذه القوة العقلية، باعتبار إدراكها للكليات، والحكم بينهما بالنسبة السلبية والإيجابية تسمى العقل النظري وباعتبار استنباطها للصناعات الفكرية، مما ينبغي أن يفعل أو يترك تسمى العقل العملي، وقد اعتنى علماء فرنسا ومن حذا حذوهم باستعمال العقل العملي وتصريفه فاستخرجوا الصنائع العجيبة والفوائد الغريبة فاقوا بها المتقدمين وأعجزوا المتأخرين رقوا بها أعلى المراقي وحصل لهم بها الذكر الباقي فلو استعملوا مع هذا العقل النظري في معرفة الله، وصفاته وفي معرفة حكمته في خلق السموات والأرض وما يلزم للإله من الكمال وما يتقدس عنه من النقص وما يمكن في حقه أن يفعله وأن لا يفعله لكانوا حازوا المرتبة، التي لا تدرك والمزية التي لا تشرك ولكنهم أهملوا استعمال هذه القوة النظرية حتى إنهم لا يسمع منهم لها ذاكرا ولا يعثر عليها في كتبهم ناظر حتى لقد حكى عن بعض علماء الوقت الآن أنه قال إن الضوء يمشي من الجسم المضيء إلى ما يقابله من الأجسام كذا وكذا متراً في كذا وكذا ثانية، أو دقيقة، وتلقى العامة منه هذا القول بالقول فلو استعمل هذا العالم قوته النظرية في حقيقته هذا الضوء لم يحكم بانتقاله لأن الضوء لا يحلو إما أن يكون جسماً أو عرضاً ولا ثالث لهما. فلو كان الضوء عرضاً يمشي من الجسم المضيء إلى ما يقابله من الأجسام كان لا ينتقل إلا بانتقال الجسم الذي قام به ذلك العرض باتفاق العقلاء إذ حقيقة العرض هو مالا يقوم بنفسه ولو كان الضوء جسماً كان لا يداخل الأجسام ولو دخل الضوء إلى بيت من طاق فسد إنسان الطاق دفعة واحدة كان يلزم أن تبقى الأجسام المضيئة في البيت على تقدير أن الضوء جسم وهو غير واقع بالمشاهدة وإنما هي حقيقة الضوء عرض يحدث في ظاهر الجسم الكثيف من مقابلة الجسم المضيء له، إذ كان بينهما جسم شفاف وإنما يحدث ذلك الضوء من السبب الذي يحدث منه ضوء الجسم المضيء كالشمس والسراج فالذي يخلق الضوء في الجس المضيء يخلق الضوء في الجسم المقابل له فالضوء عرض يجل في الجسم الكثيف ولا يحل في الهواء كما توهمه قوم بدليل أن القاعدة في غار طويل في الجبل لا يدري بالليل ولا بالنهار خارج الغار والهواء يدخل الغار بلا شك.
خاتمة الباب الأول
العلوم تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هو مذموم فالعم المحمود ما يرتبط به مصالح الدين والدنيا كالطب والحساب، وكل علم لا يستغني عنه، في قوام أمر الدين والدنيا، كأصول الصنائع من الفلاحة والحياكة، والسياسة، والحجامة بل الحجامة من العلوم اللازمة فلو خلا البلد عن الحجام تسارع الهلاك إلى أهل ذلك البلد فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله وأعد الأسباب لتعاطيه فيقبح التعرض للهلاك.ومن المعلوم، أن الإنسان مدني بالطبع فهو محتاج إلى التمدن
والاجتماع مع أنباء جنسه، ومهما اجتمع الناس في المنازل والبلاد وتعاملوا
تولدت بينهم خصومات إذ تحدث رياسة الزوج على الزوجة ورياسة الأبوين على
الولد لأنه ضعيف يحتاج على من يقوم عليه. ومهما حصلت الرياسة على عاقل
أفضى إلى الخصومة، بخلاف الرياسة على البهائم إذ ليست لها قوة المخاصمة،
ولو ظلمت أما المرأة فتنازع الزوج وأما الولد فينازع الأبوين هذا في
المنزل وأما أهل البلد فيتعاملون في الحاجات ويتنازعون فيها ولو تركوا
كذلك لتقاتلوا وهلكوا وكذلك الرعاة وأرباب الفلاحة يتنازعون على الأرض ثم
قد يعجز بعض الناس عن الصناعة بعمى أو مرض أو هرم ولو ترك ضائعاً لهلك ولو
وكل تفقده إلى الجميع لفرطوا ولو خص واحد، من غير سبب يخصه لكان لا يذعن
له. فحدث من هذه الأمور الحاصلة بالاجتماع علوم منها علم المساحة التي بها
تعرف مقادير الأرض لتمكن القسمة بينهم بالعدل ومنها علم الجندية لحراسة
البلد بالسيف ومنها صناعة الحكم لفصل الخصومات ومنها علم القانون الذي
ينبغي أن يضبط به الخلق ويلزموا الوقوف على حدوده حتى لا يكثر النزاع
وهذه، أمور مخصوصة لا يقوم بها إلا مخصوصون بالعلم والتمييز وإذا اشتغلوا
بها، لم يتفرغوا لصناعة أخرى، ويحتاجون إلى المعاش ويحتاج أهل البلد إليهم
إذ لو اشتغل أهل البلد بالحرب مع الأعداء مثلاً وتعطلت الصناعات ولو اشتغل
أهل الحرب والسلاح، بالصناعات وطلب القوت، تعطلت البلاد عن الحراس، وهلكت
الناس. فلزم أن يدهم أهل البلد بأموالهم ليحرسوهم فتحدث الحاجة إلى
الخراج، ثم يتولد بسبب الحاجة إلى الخراج علوم أخر إذ يحتاج إلى من يوظف
الخراج بالعدل على أرباب الأموال وهم العمال وإلى من يستوفي منهم بالرفق
وهم الجباة وإلى من يجمع عنده إلى وقت التفرقة الخزان وإلى من يفرق بالعدل
وهو الفارض للعساكر وهذه الأعمال لو تولاها أناس كثيرون لا يجمعهم إنسان
واحد لا نخرم النظام فحدثت الحاجة إلى ملك يدبرهم بالعلوم السياسية التي
تلزم معرفتها كل ملك فيكون الخلق كلهم بالنسبة إلى العلوم المحتاج إليها
ثلاثة طوائف الأول الفلاحون والمحترفون والثانية الجند الحماة بالسيوف
والثالثة المترددون بين الطائفتين بالأخذ والعطاء.
ثم حدث بسبب البيع والشراء الحاجة إلى التقدير فإن من يريد أن يشتري
طعاماً بثوب أين يدري المقدار الذي يساويه من الطعام كم؟ هو فلا بد من
حاكم عدل يتوسط بين المتبايعين يعدل أحدهما بالآخر فيطلب ذلك العدل من
أعيان الأموال ويحتاج إلى ما يطول بقاؤه وأبقى الأموال المعادن فاتخذت
النقود من الذهب والفضة والنحاس، فحدثت الحاجة إلي: دار الضرب، والنقش،
والتقدي وعلم المعادن واستخراجها، وتصفيتها فهذه هي علوم الخلق وهي
معايشهم، وكلها محمودة.
ثم إن هذه العلوم لا تمكن مباشرتها إلا بالتعلم والتعب في الابتداء وفي
الناس من يغفل عن ذلك في الصبا فلا يشتغل به أو يمنعه مانع فيبقى جاهلاً
وعاجزاً عن العلوم، التي يتكسب بها، فيحتاج إلى أن يأكل مما سعى فيه غيره،
فيحدث لذلك حرفتان خسيستان مذمومتان، وهما: اللصوصية والكدية ثم إن الناس
يحرزون أموالهم عن اللصوص والمكدين، فاحتاجوا إلى صرف عقولهم، في استنباط
الحيل والتدابير أما اللصوص فمنهم من يطلب أعواناً وتكون له شوكة
فيجتمعون، ويقطعون الطريف كالأعراب والأكراد، ومن فعل فعلهم وأما الضعفاء
فيستعملون الحيل: إما بنقب الدور الأسوار أو الصعود عليها، وقت غفلة
الناس، أو يكون طراراً. وأما المكدي فإنه إذ ما طلب سعى فيه غيره، قيل له:
اعمل وكل مالك وللبطالة؟ فاحتاج المكدون إلى حيلة في استخراج أموال الناس
فمنهم من يظهر العمى والفلج والمرض وهو حال عن ذلك، ليكون ذلك سببا للرحمة
عليه ومنهم من يظهر أقوالاً وأفعالاً، يتعجب الناس منها، حتى تنبسط قلوبهم
عند مشاهدتها، فيسخون لهم بالمال وذلك يكون بالتمسخر والمحاكاة والأفعال
المضحكة وقد يكون بالأشعار الغريبة مع حسن الصوت والشعر الموزون له تأثير
في النفس ويدخل في هذا الوعاظ الذين يصعدون المنابر وإذا لم يكن وراء
كلامهم علم نافع وليس مرادهم إلا اكتساب الدينار والدراهم.
وأما العلم المذموم فاعلموا وفقكم الله أن العلم لا يذم لعينه من حيث أنه علم إذ لا شيء من العلوم من حيث أنه علم بضار ولا شيء من الجهل من حيث أنه جهل بنافع لأن في كل علم منفعة إما في المعاد أو في المعاش أو الكمال الإنساني إذ كل علم يفيد النظر فيه عقلاً مزيداً وجميع العلوم الصناعية والنظرية تفيد عقلاً وإنما يذم بعض العلوم لأحد أسباب إما لكونه مؤدياً إلى ضرر إما بصاحبه أو بغيره، كعلم السحر والطلسمات وهو حق صحيح شهدت بصحته المشاهدة وهو علم، يستفاد من العلم، بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع النجوم فيحدث من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة، أحوال غريبة وتأثيرات عجيبة أعني: أن تأثيرات النفوس البشرية في عالم العناصر إن كان بغير معين من الأمور السماوية فهو السحر وإن كان بمعين من الأمور السماوية فهو الطلسمات ومعرفة هذه الأسباب من حيث أنه معرفة ليست مذمومة ولكنها ليست تصلح لا للإضرار بالخلق وكانت هذه العلوم في أهل بابل، من السريانيين والكلدانيين وفي أهل مصر من القبط وغيرهم وكان لهم فيها التآليف الكثيرة وهذا العلم مهجور في الملة الإسلامية ولم يترجم لنا من كتبهم إلا القليل إلى أن ظهر بالمشرق جابر بن حيان كبير السحرة في هذه الملة فتصفح كتب هذا العلم واستخرج الصناعة ووضع فيها التآليف وأكثر الكلام فيها، وفي صنعة الكيمياء لأنها من توابعها لأن إحالة الأجسام النوعية من صورة إلى أخرى، إنما تكون بالقوى النفسانية، لا بالصناعة العملية. وإما لكون المتعلم، يقصد بالعلم، فوق غايته، كمن يقصد بعلم النجم، الاطلاع على المغيبات، والحوادث الآتية، وغاية علم النجم: الاهتداء في ظلمات البر والبحر وتسيير الشمس والقمر في المنازل والبروج للاستعانة على الزراعة ونحوها. وأقل أحوال من يقصد بعلم النجم، الاطلاع على المغيبات، أنه خوض في فضول لا ينفع فإن المقدور واقع والاحتراز منه، غير ممكن. وأحكام النجوم ظن خالص والحكم بالظن، حكم بجهل وما يتفق من إصابة منجم، على الندور، إنما هو إنفاقي، لأن النجم يطلع على بعض الأسباب ولا يحصل المسبب عقبها، إلا بعد شروط كثيرة لا يطلع المنجم عليها. فإن قدر الله بقية الأسباب وقعت الإصابة وإن لم يقدر أخطأ ويكون ذلك: كظن الإنسان، أن السماء تمطر اليوم، إذا رأى السحاب يجتمع، وينبعث من الجبال. وربما يحمي النهار بالشمس، ويذهب السحاب!! وربما يكون المطر فالمنجم! باستدلاله بالنجم على الحوادث كاستدلال الطبيب بالنبض على ما سيحدث من المرض فتارة يكون وتارة لا يكون مع أن الطب أكثر أسبابه مما يطلع الأطباء عليها وإما لكون العلم، عزيز المنال، رفيع المرقى، ويتعاطاه من ليس من أهله، فيتضرر.
الباب الثاني
إثبات العلم الشرعي
اعلموا - وفقكم الله - أن العقل، إن بلغ من الشرف والاطلاع على حقائق الأشياء ما بلغ فثم علوم لا يصل إليها، ولا يهتدي إلى الاطلاع عليها، إلا بتصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد إليهم. بمعنى أن علوم الأنبياء، زائدة على علم العقل الذي قلنا: إنه متضمن في غريزة العقل، يجده مهما صرف عقله في اكتسابه. والعقل، مع عزله عن علوم الأنبياء، إلا باتباعهم، مستعد لقبول علومهم، والانقياد إليها، والاستحسان لها، مهما عرفوه إياها، وبيان أن ثم علوماً زائدة وراء علم العقل، أن الله - تعالى - خلق الإنسان خالياً، لا خبر له عن مخلوقات الله وهي كثيرة لا يحيط بها إلا خالقها فيخلق له حاسة اللمس، فيدرك بها الملموسات، وهي أجناس كثيرة ولا تدرك الأصوات، ولا الألوان، فهي كالمعدومة في حقه. ثم يخلق له البصر، فيدرك به بعض الموجودات، إلى أن يتجاوز المحسوسات، فيخلق فيه التمييز، وهو طور آخر، فيدرك به أموراً، وراء المحسوسات، لا يوجد شيء منها في المحسوسات. ثم يترقى إلى طور آخر، وهو طور العقل، فيدرك به أموراً، لا توجد في الأطوار التي قبله، ووراء العقل، طور آخر، وأمور أخر، العقل معزول عنها، ولا يصل إليها بنفسه، بل بغيره، كما عزلت الحواس عن مدركات العقل.فالعوم التي تحل في العقل، تنقسم إلى: عقلية وشرعية أما العقلية، فنعني بها: ما تحكم به غريزة العقل، من غير تقليد وسماع وهي تنقسم إلى:
ضرورية، كعلم الإنسان، بأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين، في
آن واحد. وبأن الشيء، لا يكون موجوداً معدوماً وهذه علوم يجد الإنسان
نفسه، عارفاً بها. ولا يدري، من أين حصل له ذلك !! أعني: لا يدري سبباً
قريباً، وإلا، فليس يخفى، أن الله، هو الذي خلقه وهداه إليه.
وإلى علوم مكتسبة، وهي المستفادة: بالتعلم، والاستدلال، والنظر.
وأما العلوم الشرعية، فهي المأخوذة عن الأنبياء، وذلك يحصل بالتعلم، لكتب
الله المنزلة، مثل: التوراة، والإنجيل والزبور، والفرقان، وفهم معانيها،
بعد السماع وبها يكمل العقل، ويسلم من الأمراض.
فالعلوم العقلية، غير كافية في السلامة، وإن كان محتاجاً إليها كما أن
العقل، غير كاف، في استدامة صحة البدن، بل يحتاج الإنسان، إلى معرفة خواص
الأدوية والعقاقير، بطرق التعلم، من الأطباء، إذ مجرد العقل، لا يصل إليه،
ولكن لا يمكن فهمه، بعد سماعه، إلا بالعقل، فلا غنى بالعقل، عن العلوم
الشرعية ولا غنى بها، عن العقل. الذي يدعوا الناس إلى التقليد المحض، مع
عزل العقل، جاهل والمكتفي بمجرد العقل، عن العلوم الشعرية، مغرور فإياكم
أن تكونوا من أحد الفريقين، وكونوا جامعين بينما. فإن العلوم العقلية
كالأغذية والعلوم الشرعية كالأدوية، والشخص المريض يتضرر بالغذاء إذا فاته
الدواء وقلوب الخلق كلها مرضى.
ولا علاج لها، إلا بالأدوية، التي ركبها الأنبياء. وهي وظائف العبادات.
فمن اكتفى بالعلوم العقلية، تضرر بها كما يتضرر المريض بالغذاء كما وقع
لبعض الناس، فإنهم قالوا: الإنسان، إذا حصل له المعقول وأثبت للعالم
صانعاً وصل إلى الكمال المطلق. فتكون سعادته، على قدر علمه. وشقاوته على
قدر جهله. وعقله، هو الذي يوصله إلى هذه السعادة.
وإياكم أن تظنوا، أن العلوم الشرعية مناقضة، ومنافرة للعلوم العقلية، بل
كل شيء جاء عن الأنبياء، مما شرعوه للناس، لا يخالف العقول السليمة، نعم،
يكون في شرائع الأنبياء، ما تستبعده العقول، لقصورها عنه، فإذا عرفت طريقه
عرفت أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه: مثاله في شرع الإسلام: الذهب
والفضة فإن الشرع يمنع من اختزانهما من غير إعطاء بعضها للفقراء
والمساكين، ويمنع من اتخاذ الأواني للأكل والشرب منها. ويمنع من بيع الذهب
بالذهب والفضة بالفضة، بزيادة. فإذا قيل لإنسان: أعط بعضها للفقراء، وإلا
تحرق بالنار، يقول: أنا تعبت وجمعتها، فكيف أعطيها من كان نائماً مستريحاً
هذا خارج عن العقل وإذا قيل له: لا تأكل ولا تشرب، في أواني الذهب والفضة،
وإلا تحرق بالنار، يقول: أنا أتصرف في ملكي. ولا ينازعني فيه أحد فيكف
أعاقب على التصرف في ملكي هذا خارج عن العقل!! وإذا قيل له: لا تبع الذهب
بالذهب، ولا الفضة بالفضة، بزيادة. وإلا تحرق بالنار. يقول: أنا أبيع
وأشتري، برضاً مني، ومن الذي أتعامل معه. ولولا البيع والشراء، لخربت
الدنيا. وتعطلت المنافع، هذا شيء خارج عن العقل وكلامه هذه صحيح، فإن
العقل، غير مدرج للعقاب، على هذه الأمور. فيحتاج العقل إلى التعريف فيقال
له: الحكمة، التي خلق الله الذهب والفضة لأجلها، هي أن قوام الدنيا بهما.
وهما حجران، لا منفعة في أعيانهما، إذ لا يردان حراً، ولا برداً، ولا
يغذيان جسماً.
والخلق - كلهم - محتاج إليهما، من حيث أن كل إنسان محتاج إلى أشياء كثيرة
في مطعمه وملبسه. وقد لا يملك ما يحتاج إليه. ويملك ما يستغني عنه، كمن
يملك القمح مثلاً، وهو محتاج إلى فرس. والذي يملك الفرس، قد يستغني عنه،
ويحتاج إلى البر. فلا بد - بينهما - من معارضة. ولا بد من تقدير العوض إذ
لا يعطى صاحب الفرس فرسه. بكل مقدار من البر، ولا مناسبة بين البر والفرس
حتى يقال: يعطى منه، مثله في الوزن أو الصورة، فلا يدري، أن الفرس، كم
يسوى بالبر؟ فتتعذر المعاملات، في هذا المثال، وأشباهه، فاحتاج الناس إلى
متوسط، يحكم بينهم بالعدل، فخلق الله الذهب والفضة، حاكمين بين الناس، في
جميع المعاملات، فيقال: هذا الفرس، يسوى مائة دينار. وهذا القدر من البر،
يسوى مثله. وإنما كان التعديل بالذهب والفضة، لأنه، لا غرض في أعيانهما.
وإنما خلقهما الله لتتداولهما الأيدي، ويكونا حاكمين بالعدل.
ونسبتهما إلى جميع الأموال، نسبة واحدة. فمن ملكهما، كأنه ملك كل
شيء. ومن ملك فرنسا - مثلاً - فإنه لم يملك، إلا ذلك الفرس، فلو احتاج إلى
طعام، ربما لم يرغب صحب الطعام في الفرس، لأن غرضه في ثوب مثلاً، فاحتيج
إلى ما هو في صورته، كأنه ليس بشيء، وهو - في معناه - كأنه كل الأشياء
والشيء، إنما يستوي نسبته، إلى الأشياء المختلفات، إذا لم تكن له صورة
خاصة. كالمرآة، لا لون لها، وتحكى كل لون.
فكذلك الذهب والفضة، لا غرض فيهما، وهما وسيلتان إلى كل غرض. فكل من عمل
فيهما عملاً، لا يليق بالحكمة الإلهية.
فإنه يعاقب بالنار، إن لم يقع السماح، فمن كنزهما، من غير أن يعطى منهما
قدراً مخصوصاً للفقراء، فقد أبطل الحكمة فيهما. وكان كمن حبس الحاكم، الذي
بين الناس، ويقطع الخصومات، في سجنٍ، يمتنع عليه الحكم بسببه، لأنه إذا
كنزهما، فقد ضيع الحكم: وما خلق الله الذهب والفضة، لزيد خاصة. ولا لعمرة
خاصة. وإنما خلقهما، لتتداولهما الأيدي، ليكونا حاكمين بين الناس ولا شك،
أن العقل، إذا عرف هذا الذي قلناه، حكم: بأن ادخار الذهب والفضة عن الناس،
ظلم. واستحسن العقوبة عليه، لأن الله تعالى، لم يخلق أحداً للضياع، ونما
جعل عيش الفقراء على الأغنياء، ولكن الأغنياء، ظلموا الفقراء ومنعوهم
حقهم، الذي جعله الله لهم.
وكذا نقول: من اتخذ من الذهب والفضة آنية للأكل والشرب، فهو ظالم وكان أشر
من الذي كنزهما وادخرهما.
لأن مثال هذا مثال من جعل حاكم البلد، حجاماً أو درازاً، أو جزاراً.. من
الأعمال، التي يقوم بها أخساء الناس لأن النحاس والرصاص والطين، تنوب مناب
الذهب والفضة، في حفظ المأكولات والمشروبات، عن التبديد. وفائدة الأواني
حفظ المائعات. ولا يكفي الطين والحديد والرصاص والنحاس في المقصود الذي
يراد من الذهب والفضة. ولا شك، أن العقل إذا عرف هذا، لم يتوقف في
استحسانه، واستحسان العقوبة عليه.
وكذا نقول: من باع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة بزيادة فقد، جعلهما
مقصودين في ذاتهما للتجارة. وذلك خلاف الحكمة الإلهية لأن من عنده ثوب
مثلاً، وليس عنده ذهب ولا فضة، وهو محتاج إلى طعام فقد لا يقدر أن يشتري
الطعام بالثوب: فهو معذور في بيعه بالذهب أو الفضة، فيتوصل إلى مقصوده،
فإنهما وسيلتان إلى الغير، لا غرض في أعيانهما فأما من عنده ذهب، فأراد
بيعه بذهب، أو فضة، فأرد بيعها بفضة، فإنه يمنع من ذلك.. لأنه يبقى الذهب
والفضة متقيدين محبوسين عنده. ويكون، بمنزلة الذي كنز. وتقييد الحاكم، أو
الرسول الموصل الحاجات إلى الغير، ظلم. فلا معنى لبيع الذهب بالذهب،
والفضة بالفضة، إلا اتخاذهما مقصودين للادخار، فإذا عرف العقل هذا، حسنه،
وحسن العقوبة عليه وإنما كان بيع الذهب بالفضة، والعكس، لا عقوبة عليه،
لأن أحدهما، يخالف الأخر، في التوصل إلى قضاء الحاجات إذ يسهل التوصل
بالفضة، من جهة كثرتها، فتتفرق في الحاجات، والمنع، تشويش للمقصود به. وهو
تسهيل التوصل به إلى غيره. وكذا تقول: لمن يبيع الفضة أو الذهب بزيادة إلى
أجل كمن يبيع عشرةً، بعشرين، إلى سنة إن مبنى الاجتماع، وأساس الأديان هو
استعمال ما يوجب المحبة والألفة، فيحصل التناصر والتعاون. والإنسان، إذا
كان محتاجاً، ووجد من يسلفه فلا شك، أنه يتقلد منة من أسلفه، ويعتقد
محبته، ويرى أن نصرته وإعانته، أمر لازم له ففي منع بيع الذهب والفضة،
بزيادة إلى أجل، إبقاء لمنفعة السلف التي هي من أجل المقاصد.
وهذا الذي ذكرناه، جزئية من كليات، تبين: أن الشرع لا يخالف العقل. وقس
عليه: جميع ما أمرت به الأنبياء ونهت عنه، فجميع أقوال الأنبياء، لا تخالف
العقول. ولكن فيها ما لا يهتدي العقل إليه، أولاً: فإذا هدي إليه، عرفه
وأذعن له. وكما يطلع الطبيب الحاذق على أسرار في المعالجات، يستبعدها من
لا يعرفها، فكذلك الأنبياء، فلا يصل العقل إلى علومهم، إلا بتعريفهم.
ويلزم العاقل، التسليم لهم، بعد النظر في صدقهم فكم من شخص يصيبه مرض في
إصبعه فيقتضي عقله، أن يطليه بالدواء. حتى ينبهه الطبيب الحاذق: أن علاجه،
أن يطلي الكتف، من الجانب الآخر، من البدن، فيستبعد ذلك، غاية الاستبعاد،
فإذا عرفه الطبيب، كيفيه إنشعاب الأعصاب ومنابتها، ووجه التفافها على
البدن، أذعن.
إثبات النبوة واحتياج كافة العقلاء إلى علوم الأنبياء
اعلموا - وفقكم الله - أن النبوة، هي عبارة عن طور، تنفتح فيه عين أخرى، زائدة على طور العقل، ونظره، ينظر بها النبي، ما يكون في المستقبل، من أمور، العقل معزول عن إدراكها كعزل قوة التمييز، عن إدراك المعقولات وكعزل الحواس، عن مدركات التمييز وانظروا إلى ذوق الشعر. كيف يختص به قوم من الناس، وهو نوع إحساس وإدراك ويحرم منه بعضهم وانظر كيف عظمت قوة هذا الذوق في طائفة حتى استخرجوا بها الموسيقى والأغاني والأوتار ونحوها، التي منها: الحازن، والمطرب، والمبكي، والمضحك، والقاتل، والموجب للغشي، وإنما يقوى على استنباط هذه الأنواع من قوى له أصل الذوق، وأما العاطل عن خاصية هذه الذوق فيشاركه في سماع الصوت، وتضعف فيه هذه الآثار، وهو يتعجب من صاحب الوجد والغشى، ولو اجتمع العقلاء - كلهم - من أرباب الذوق على تفهيمه معنى الذوق، لم يقدروا.0 فلا تجعلوا الكمال وقفاً على العقل، فوراء كمال العقل، كمال آخر أعلى من كمال العقل، وكما أن المميز لو عرضت عليه مدركات العقل، لأنكرها واستبعدها فكذلك بعض العقلاء استبعدوا مدركات النبوة ولا مستند لاستبعادها، إلا أنها طور، لم تبلغه العقول، وقد خلق الله مثالاً للنبوة.من حيث أنها إدراك، زائد على الإدراك المتعارف وهو النوم. إذ النائم يدرك أموراً، تكون في المستقبل إما صريحاً، وإما بإشارة يعرفها المعبرون للرؤيا وهذا لو لم يجربه الإنسان من نفسه، وقيل له: إن من الناس، من يسقط كالميت، ويزول إحساسه وسمعه وبصره، فيدرك المغيبات، لأنكره وقال: القوى الحسية، أسباب الإدراك، والإنسان، لا يدرك المغيبات، مع وجود حواسه، فكيف يدرك مع غيبتها، والوجود والمشاهدة، قاضيان بصحة النوم. وقد شاهدنا صحة كثير من المنامات وبلغنا عن الثقات، بالنقل الصحيح أن الفردوسي الشاعر، لما صنف كتابه، المسمى بشاهنامه على اسم السلطان محمود بن سبكتكين وأنه ما قضى حقه كما يلزم وما راعاه كما يليق بذلك الكتاب، ضاق قلب الفردوسي، فرأى رستم في المنام، فقال له: إنك مدحتني في هذا الكتاب كثيراً، وأنا في حملة الأموات، فلا أقدر على قضاء حقك، ولكن اذهب إلى الموضع الفلاني واحفر، فإنك تجد فيه دفيناً، كنت دفنته، فخذه فذهب فوجده، وأخذه، فكان الفردوسي يقول: إن رستم - بعد موته - كان أكثر كرماً، من محمود حال حياته.
والشك في النبوة، إما أن يكون في إمكانها، أو وجودها، و حصولها لشخص معين. ودليل إمكانها وجودها، وجود معارف في العالم، لا يمكن أن تدرك بالعقل، كعلم الطب وعلم النجم، فإن من بحث في علميهما، علم يقيناً، أن بعضها لا يدرك، إلا من جهة الله تعالى، ولا تكون التجربة طريقاً إليها، فإن من الأحكام النجومية، ما لا يقع في كل ألف سنة مرة. فكيف يحصل ذلك العلم بالتجربة؟ وكذلك خواص الأدوية فظهر بهذا أن من الممكن، وجود طريق إدراك هذه الأمور، التي لا يدركها العقل. وهو المراد بالنبوة.
وثم أمور، تسمى خواص لا يدور العقل حولها أصلاً فإن وزن دانق، من الأفيون، سم قاتل لأنه يجمد الدم في العروق، لقوة برودته والعالم بالطبيعيات يقول أنه يبرد، لأنه من المبردات، التي يغلب فيها عنصر الماء والتراب، ومعلوم أن أرطالاً من الماء والتراب، لا يبلغ تبريدها، إلى هذا الحد، ولو أخبر طبيب بهذا، ولم يجربه، لقال: هذا كذب، لأن الماء والتراب، لو كانا وحدهما، ما وصلا إلى هذا الحد، والأفيون، فيه هوائية ونارية، فإذا جربه، التزم أن يقول: إن في الأفيون خاصية في التبريد، خارجة عن قياس المعقول.
ولو قيل لإنسان: هل يمكن أن يكون، في الدنيا، شيء هو بمقدار حبة، في بلدة، فيأكل تلك البلدة بجملتها، ثم يأكل نفسه، فلا يبقى شيء في البلدة، وما فيها. ولا يبقى هو في نفسه، لقال: هذه محال، وهو من جملة الخرافات وهذه حالة، ينكرها من لم ير النار، وأكثر العجائب التي يخبر بها الأنبياء، من هذا المعنى.
وإذا ثبت، أن الله تعالى، فاعل مختار، لا علة موجبة. وثبت، أن إرسال الأنبياء، ممكن غير محال في حقه وجاءت الأنبياء، بما يصدقهم، من المعجزات الخارقة للعادة، لزم تصديقهم.
والدليل على أن الله تعالى، فاعل مختار، هو أن هذه الأجسام
الموجودة متناهية وكل متناه فهو مشكل ينتج: أن هذه الأجسام الموجودة،
مشكلة وهذه الأشكال قسمان: أحدهما: الأشكال التي حصلت على سبيل الاتفاق،
من غير أن يحتاج حصولها، إلى فعل فاعل حكيم.
والثاني الإشكال، التي يشهد صريح العقل بأنها لم تحصل إلا بقصد فاعل حكيم.
أما القسم الأول، فمثل الحجر المنكسر، والكوز المنكسر، فإنه لا بد وأن
يكون لتلك القطعة من الحجر والفخار شكل مخصوص معين. إلا أن صريح العقل،
شاهد بأن ذلك الشكل المخصوص، وقع على سبيل الاتفاق ولا يتوقف حصوله، على
فعل فاعل مختار.
وأما القسم الثاني فهو مثل الأشكال، الواقعة على وفق المصالح والمنافع،
مثله، الإبريق، فإننا لما نظرنا إلى الإبريق، رأينا فيه ثلاثة أشياء:
أحدها، الرأس الواسع، وثانيها، البلبلة الضيقة، وثالثها، العروة، فلما
تأملنا، هذه الأحوال الثلاثة، وجدناها موافقة لمصلحة الخلق، فإنه لا بد من
توسيع رأس الإبريق، حتى يدخل الماء فيه بالسهولة ولا بد من ضيق بلبلته حتى
يخرج الماء منها بقدر الحاجة، ولا بد له من العروة، حتى يقدر الإنسان على
أن يأخذه بيده، فلما وجدنا هذه الأوصاف الثلاثة، في الإبريق مطابقة
للمصلحة، شهد عقل كل واحد، بأن فاعل هذا الإبريق، لا بد وأن يكون قد فعله
بناء على الحكمة، ورعاية المصلحة ولو أن قائلاً قال: إن هذا الإبريق تكون
بنفسه، من غير قاصد حكيم، ولا فعل فاعل.
بل اتفق تكونه بنفسه، كما اتفق تشكل هذه القطعة، بهذا الشكل الخاص، من غير
قصد قاصد حكيم، ولا جعل جاعل، لشهدت الفطرة السلمية بأن هذا القول، باطل
محال. ومتى ثبت القول بالفاعل المختار،، ثبت حدوث العالم. ومن عرف هذا،
سهل عليه معرفة النبي، فإن من دخل بستاناً ورأى أزهاراً حادثة، بعد أن لم
تكن. ثم رأى عنقود عنب، قد اسود جميع حباته، إلا حبة واحدة، مع تساوي نسبة
الماء والهواء وحر الشمس، إلى جميع تلك الحبات، فإنه يضطر إلى العلم بأن
فاعله مختار، وحينئذ تحصل المعرفة الضرورية بصدق الرسول لأن دلالة
المعجزة، على صدق الرسول،ضرورية.
تنبيه معرفة النبي
إذا وقع لكم الشك في شخص معين أنه نبي أم لا، فلا يحصل لكم اليقين، إلا بمعرفة أحواله. إما بالمشاهدة، وإما بالتسامع والتواتر. فإنكم إذا عرفتم الطب والحكمة مثلاً، يمكنكم أن تعرفوا الأطباء والحكماء، بمشاهدة أحوالهم، وسماع أقولهم، وإن لم تشاهدوهم، فلا تعجزون عن معرفة كون جالينوس طبيباً، وكون أفلاطون حكيماً، معرفة بالحقيقية، لا بالتقليد للغير بأن تطالعوا كتبهما، وتصانيفهما، بعد معرفتكم بالطب والحكمة فيحصل لكم العلم الضروري بحالها، فإذا فهمتم معنى النبوة فأكثروا من مطالعة كتب الأنبياء، وأخبارهم، وكيف كانت سيرهم وأحوالهم، فإذا قال قائل: إن هذا المنقول عنهم، خرافات وكذب، فنقول له: ما بال الناس، لا ينقلون نقلاً متواتراً، عن غير الأنبياء، مثل ما نقلوا عن الأنبياء وأكثر الأمور، التي نقلت عن الأنبياء، مما يدل على صدقهم، متواترة يجزم العقل بأنها موجودة. والتواتر مفيد للعلم وحقيقة التواتر هو أن يخبر جماعة يبعد تواطؤهم على الكذب عادة، عن أمر محسوس، فيحكم العقل به، بمجرد خبرهم، فيحصل العلم الضروري - ولا شك - في هذا، إذ لا طريق للعلم الضروري بالبلاد البعيدة مثل الصين وأمريكة والأشخاص الماضية كحاتم وعنترة وجالينوس وأرسطو، إلا بالتواتر وجميع الأنبياء، إنما ثبتت نبوتهم، عندنا، وعند كل من لم يشاهدهم ويعاصرهم بالتواتر. لأنه نقل إلينا - بالتواتر - أحوالهم، وسيرهم، وظهور الخوارق على أيديهم. فإن رددنا التواتر، وما قبلناه واقتصرنا على ما نشاهده، يلزمنا بطلان نبوة جميع الأنبياء بل يلزمنا عدم التصديق بوجود البلاد التي لم نشاهدها وعدم الأشخاص الذين لم نشاهدهم. وهو ظاهر البطلان وإن اعترفنا بصحة التواتر، لزمنا الاعتراف بنبوة جميع الأنبياء.والنبي، يدعو الناس، إلى عبادة الله ولا ضرر عليه، لو خالفه
الناس أجمعون، ومثال الرسول، مع الذين ما صدقوه، ولا أجالوا خواطرهم،
بالنظر إلى صحة قوله، مثال رجلٍ يقول لآخر: إن وراءك سبعاً ضارباً. فإن لم
تهرب، قتلك وإن التفت وراءك ونظرت، عرفت صدقي فيقول الواقف: أنه لا يثبت
صدقك عندي، إلا إذا نظرت والتفت ورائي، ولا ألتفت ورائي إلا إذا ثبت صدقك،
وهذا كلام يدل على حماقة هذا القائل، وتعرضه للمهالك ولا ضرر فيه على هذا
المخبر فكذلك الرسول يقول: ورائكم الموت، ووراء الموت السباع الضارية،
والنيران المحرقة فإن لم تحذروا منها، وتعرفوا صدقي، بالنظر في أحوالي،
ومعجزاتي، هلكتم، فمن التفت ونظر، عرف ونجا، ومن لم يلتفت، ولم ينظر، هلك.
ولا ضرر علي، ولو هلك الناس أجمعون، فالرسول يعرف بوجود السباع الضارية،
بعد الموت. والعقل يفهم كلامه، ويحكم بإمكان وقوع ما يقوله في المستقبل.
والطبع، من شأنه الحذر من الضرر.
وأساس الديانة، وأصولها، لا خلاف فيها، بين الأنبياء من آدم، إلى محمد،
فكلهم، يدعون الخلق إلى توحيد الإله، وتعظيمه واعتقاد أن كل شيء، ولا علة
لوجوده، هو - سبحانه وتعالى - وإلى حفظ النفس والعقل، والنسل والمال، فهذه
الكليات الخمس، لا خلاف فيها، بين الأنبياء، وجميع الشرائع متفقة عليها.
وحاصلها يرجع إلى تعظيم الإله، والشفقة على مخلوقاته.
وطريان النسخ على هذه الكليات الخمس: محال. وإنما النسخ، يمكن في الشرائع
الوضعية وهي الأشياء، التي يجوز ويصح أن لا تكون مشروعة، دون الأحكام
العقلية، كتوحيد الإله، وما ذكرنا معه من الكليات فإن العقول والشرائع،
متوافقة على لزوم حفظها، والخلاف بين الأنبياء في كيفية حفظها، ووضع
القوانين، لدوام بقائها محفوظة.
وفائدة النسخ وحكمته، إما على تقدير، كون الأحكام الشرعية، معللة بمصالح
العباد، واللطف بهم، فيكمن أن تختلف مصالح الأوقات، فتختلف الأحكام
بحسبها. كمعالجة الطبيب، فإنه قد يأمر بشرب دواء خاص، في وقت، دون وقت
فربما كانت المصلحة، في وقت آخر، ارتفاعه، لاشتماله على شيء، تلزم رعايته،
وفي وقت آخر، ارتفاعه، لاشتمال رفعه، على مصلحة أخرى، حادثة بعد زوال
الأولى، وما على تقدير، أن الأحكام الشرعية، مستندة إلى محض إرادة الله،
من غير مراعاة مصلحة، فالأمر هين، لأنه - تعالى - هو الحاكم المطلق،
الفعال لما يريد. فيجب أن يضع حكماً، ويرفع حكماً، لا لعلة وغرض، فكما لا
تنافي، بين الأمر المقتضي لوجود الحادث، في ورقت وبين الأمر، المقتضى
لفنائه، في وقت آخر، كذلك ليس بين تحليل الشيء، في زمان، وتحريمه في زمان
آخر، تناف أصلاً.
وكان أن مدة بقاء كل حادث، وزمان فنائه، معين في علم الله - تعالى - وإن
كان مجهولاً لنا، كذلك مدة بقاء كل حكم، وزمن تغيره، كان معيناً في علم
الله وإن كان مجهولاً لأهل الأديان السابقة فالتحالف بين شرائع الأنبياء،
في جزئيات الأحكام سبب تفاوت الأعصار، في المصالح، من حيث أن كل واحد من
الأحكام، حق، بالإضافة إلى أهل زمانه، مراعى فيه، مصالح من خوطب به
فالنسخ، إنما هو للأحكام لا لنبوة النبي، المنسوخة شريعته، فإن النبوة،
صفة لا تزول عمن اتصف بها واليهود، منعوا النسخ، فأنكروا الإنجيل، وذلك أن
الإنجيل النازل على المسيح، وإن لم يكن في أحكام من الحلال والحرام، إنما
هو رموز وأمثال ومواعظ والأحكام فيه محالة على التوراة
إلا أن فيه إشارة لنسخ بعض أحكامها. وقالوا:إن عيسى مأمور باتباع
التوراة، وموافقة موسى فغير وبدل!! وعدوا من التغييرات، تغيير السبت إلى
الأحد ومنها، أكل بعض ما كان حراماً في التوراة، ومنها، الختان، وكان
لازماً في التوراة. ومنها الغسل من الجناية، وكان لازماً في التوراة،
ومنها، زوال النجاسة، وكان لازماً في التوراة، وغير ذلك. واحتجت اليهود
بأن موسى، نفى نسخ دينه. ويلزم الاعتراف بصدقة، لكونه نبياً بالاتفاق وذلك
أنه قال - بالتواتر - تمسكوا بالسبت، مادامت السموات والأرض والمراد
بدوامه، دوام اليهودية، كما هو ظاهر اللفظ. واحتجوا أيضاً بأن موسى، إما
أن يكون صرح بدوام دينه، أو بعدم دوامه، أو سكت، والأخيران باطلان، أما
تصريحه، بعدم دوام دينه، فإنه لو قال ذلك: لتواتر عنه، لكونه من الأمور
العظيمة، التي تتوفر الدواعي على نقلها، وإشاعتها. لا سيما من الأعداء،
ومن يدعي نسخ دينه لأنه أقوى حجة له في نسخه، لكنه لم يتواتر باتفاق وأما
الثالث وهو سكوته يقتضي ثبوت دينه، مرة واحدة، وعدم تكرره لأن الشيء، إذا
أطلق، يتحقق بالمرة الواحدة، وهذا معلوم البطلان، لتقرر شرع موسى، إلى وقت
ظهور المسيح، فأجابهم النصارى، المصدقون للمسيح، القائلون: بأن نسخ
الشرائع، ممكن، بأن تواتر دوام السبت، عن موسى، باطل. ولو كان متواتراً -
كما زعمتم - لاحتج به على المسيح، ولو احتج به عليه، لنقل إلينا متواتراً،
لتوفر الدواعي على نقله، ولا تواتر.
وأما قولكم: أكان صرح بدوام دينه، أو بعدم دوامه، أو سكت فجوابه: أنه صرح
بدوامه، إلى ظهور الناسخ، وهو المسيح، وإنما لم ينقل ذلك - تواتراً - لقلة
الدواعي منهم إلى نقله، لما فيه من الحجة عليهم.
والنسخ - في الحقيقة - ليس هو إبطالاً، وإنما هو تكميل. وفي التوراة:
أحكام عامة، وأحكام مخصوصة، إما بأشخاص وإما بأزمان. وإذا انتهى ذلك
الزمن، لم يبق ذلك الحكم، لا محالة، ولا يقال: إنه إبطال. واليهود، لو
عرفوا لم ورد التكليف بملازمة السبت؟ وهو يوم أي شخص من الأشخاص؟ وفي
مقابلة أية حال؟ وجزء أي زمن؟! عرفوا أن شريعة المسيح حق واليهود، هم
الذين اعتدوا في السبت، فمسخهم الله قردة وخنازير، وقال المسيح: ما جئت
لإبطال التوراة، بل جئت لأكملها قال صاحب التوراة: النفس بالنفس، والعين
بالعين، والأنف بالأنف، والجروح قصاص، وأنا أقول: إذا لطمك أخوك على خدك
الأيمن، فضع له خدك الأيسر وجواب النصارى لليهود هو جواب المسلمين
للنصارى، والذي قاله المسيح، قاله محمد.
فإنه قال: ما جئت لأبطل الإنجيل والتوراة وإنما جئت لأكملهما ففي التوراة أحكام السياسة الظاهرة العامة. وفي الإنجيل أحكام السياسة الباطنة الخاصة، وأنا جئت بالسياستين جميعاً جئت بالقصاص " ولكم في القصاص حياة " وهو إشارة إلى السياسة الظاهرة العامة وجئت بالعفو " أن تعفو أقرب للتقوى " ، " خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين " وهو إشارة إلى السياسة الباطنة الخاصة وهذا دليل، على أن محمداً صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين لأن النبوة: حكمة والحكمة، إما عملية، أو علمية، أو جامعة بينهما. وحكمة موسى، كانت عملية لاشتمالها على تكاليف شاقة، وأعمال متعبة. وحكمة المسيح، كانت علمية، لاشتمالها على التجرد والروحانيات والتصوف المحض وحكمة محمد جامعة بينهما فلا يجيء نبي بعده، غير المسيح فإنه ينزله ثانياً إلى الأرض لأن الذي يجيء بعد محمد، إن كانت حكمته عملية، فموسوي، وإن كانت حكمته عملية، فمسيحي، وإن كانت جامعة بينهما، فمحمدي، فقد انختمت عليه النبوة، بالضرورة، فالدين واجد باتفاق الأنبياء. وإنما اختلفوا في بعض القوانين الجزئية، فهم كرجال أبوهم واحد، وأمهاتهم متعددة فتكذيب جميعهم، أو تكذيب البعض وتصديق البعض: قصور. ولو أصغى إلى المسلمون والنصارى، لرفعت الخلاف بينهم، ولصاروا إخواناً، ظاهراً وباطناً، ولكن لا يصغون إليّ، لما سبق في علم الله أنه لا يجمعهم على رأي واحد ولا يرفع الخلاف بينهم، إلا المسيح عند نزوله ولا يجمعهم، لمجرد كلامه مع أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص ولا يجمعهم، إلا بالسيف والقتل، لو جاءني من يريد معرفة طريق الحق، وكان يفهم لساني فهماً كاملاً لأوصلته إلى طريق الحق، مت غير تعب، لا بأن يقلدني، بل بأن يظهر الحق له، حتى يعترف به اضطراراً وعلوم الأنبياء، من حيث خطابهم للعامة: دائرة على ما يصلح الناس، في معاشهم ومعادهم. وما جاءوا ليجادلوا الفلاسفة ولا لإبطال علوم لطب، ولا علوم النجم، ولا علوم الهندسة وإنما جاءوا باعتبار هذه العلوم على وجه، لا يناقض التوحيد، ونسبة كل ما يحدث في العالم، على قدرته، وإرادته سبحانه، فما جاءوا لمنازعة من يقول: الجسم، مركب من العناصر الأربعة ولا من يقول: إن الأرض كروية الشكل، ولا من يقول: إن خسوف القمر، بسبب توسط الأرض بينه وبين الشمس، فإن أمثال هذه الأمور، لا تضاد ما جاءت به الأنبياء، وبحث الأنبياء في العالم إنما هو عن كونه حادثاً أو قديماً ثم إذا ثبت حدوثه، فسواء كان كرةً أو بسيطاً، وسواء كانت السموات وما تحتها، ثلاث عشرة طبقة، أو أقل أو أكثر.. فالمقصود، كونه من فعل الله ومن قال: هذا مناقض للدين، أو المنازعة فيه، من الدين فقد جنى على الدين، وضرر الشرع من جهة من ينصره، لا بطريقته أكثر ممن يطعن فيه.
خاتمة تكذيب الأنبياء
إن المكذب للأنبياء المستغنى بعقله عما جاءوا به من الأعمال والعبادات مغرور، وكل ما جاء في فضل العلم، وذم الجهل فهو دليل، على ذم الغرور، لأن الغرور عبارة عن بعض أنواع الجهل إذ الجهل، هو أن يعتقد الشيء،على خلاف ما هو عليه، فمهما كان الإنسان يعتقد شيئاً يوافق هواه، وكان السبب الموجب لاعتقاده، دليلاً فاسداً، فهو مغرور، وأنواع الغرور والمغرورون، كثيرا ونذكر نوعاً واحداً، وهم الذين غرتهم الدنيا، فنقول: قال الذين غرتهم الدنيا: الحاضر خير من المنتظر والدنيا حاضرة والآخرة منتظرة، فالدنيا خير فلا بد من الاشتغال به، وبما يصلحها، وقالوا: اليقين خير من الشك ولذا الدنيا، يقين، ولذات الآخرة شك. فلا نترك اليقين، لأجل الشك ودواء هذا إما بتصديق الأنبياء فيما قالوا وإما بالدليل والبرهان.أما تصديق الأنبياء - مجرداً - فهو مرتبة العوام. ويخرج المصدق لهم من الغرور، وينزل هذا منزلة تصديق الصبي والده، في أن حضور المكتب، خير من حضور اللعب، مع أنه لا يدري وجه كونه خيراً.
وأما البرهان: فهو أن يعرف فساد هذا الدليل، وفيه أصلان:
أحدهما: أن الدنيا حاضرة، والآخرة منتظرة وهذا صحيح. والآخر: أن
الحاضر، خير من المنتظر، وليس كذلك بل إن كان الحاضر مثل المنتظر في
المقدار، فهو خير وإن كان أقل منه، فالمنتظر خير. فإن غير المغرور، يبذل
في تجارته درهماً، ليأخذ عشرة منتظرة، ولا يقول: الحاضر خير من المنتظر،
فلا أتركه. وإذا حذره الطبيب، من أكل الفواكه، ولذائذ الأطعمة، ترك ذلك في
الحال. خوفاً من ألم المرض، في المستقبل، فقد ترك الحاضر ورضى بالمنتظر.
والتجار كلهم يركبون البحار، ويتعبون في الأسفار، حاضراً، لأجل الربح
والراحة في المستقبل، فإن كان عشرة في المستقبل خيراً من واحد في الحاضر.
فأنسب لذة الدنيا، منى حيث مدتها إلى مدة الآخرة فإن غاية عمر الإنسان
مائة سنة، وليس هو عشر عشر، من جزء، من مائة ألف ألف جزء، من الآخرة فإنه
ترك واحداً ليأخذ ألف الف بل يأخذ ما لا نهاية له، ولا حد، وإن نظر من حيث
اللذة، رأى لذة الدنيا مكدرة، مشوبة بأنواع المنغصات. ولذة الآخرة صافية،
غير مكدرة، فإذاً: أنه غلط في قوله: الحاضر خير من المنتظر.
وأما الدليل الآخر، وهو قوله: اليقين خير من الشك، والدنيا يقين، فهو أكثر
فساداً من الأول، إذ اليقين، خير من الشك، إذا كان مثله. وإلا فالتاجر -
في تعبه - على يقين، وفي ربحه على شك. والمتعلم في اجتهاده وتعبه على
يقين، وفي إدراكه رتبة العلماء على شك والصياد، في تردده في مواضع الصيد،
على يقين وفي الظفر بالصيد،على شك وكل هذا ترك لليقين بالشك، ولكن التاجر
يقول: إن لم أتجر بقيت جائعاً وإن اتجرت، كان تعبي قليلاً، وربحي كثيراً
وكذلك المريض يشرب الدواء المر، وهو ما لشفاء، على شك ومن مرارة الدواء،
على يقين لكن يقول: ضرر مرارة الدواء قليل، بالنسبة إلى ما أخافه، من
المرض والموت، فكذلك، من شك فيما قاله الأنبياء، في الآخرة، بعد الموت،
فلازم له، بحكم العقل، والحزم الذي هو دأب العقلاء، أن يقول: الصبر أياماً
قلائل - وهو مدة العمر - قليل، بالنسبة إلى ما يقال، من أمور الآخرة، فإن
كان ما قيل، كذباً فلا تفوتني إلا الراحة، والتنعم أيام عمري. وإن كان ما
قيل صدقاً، فأبقى في النار، أبد الآباد، وهذا لا يطاق ولهذا قال بعض
المصدقين للأنبياء لبعض المكذبين: يا هذا!! إن كان الذي قلته أنت حقاً فقد
تخلصت وتخلصنا. وأن كان الذي قلته أنا حقاً فقد تخلصنا، وهلكت أنت.
وأما الأصل الثاني وهو أن الآخرة شك فهو خطأ، بل هو يقين عند العقلاء.
وطريق زوال هذا الغرور، هو التصديق للأنبياء والعلماء، بوجود الآخرة، وما
أعد الله فيها للمطيعين والعاصين ومثاله، مثال المريض لا يعرف دواء علته
وقد اتفق الأطباء كلهم: على أن دواءه النبت الفلاني فإن المريض يصدقهم،
ولا يطالبهم بالبرهان على صحة قولهم. بل يتيقن بقولهم ويعمل به، ولو بقي
معتوه أو صبي، يكذبهم في ذلك إذ المريض يعلم أنهم أكثر عدداً، ممن كذبهم.
وأعظم منه فضلاً، وأعلم منه بالطب، ولو ركن المريض إلى قول المعتوه، وترك
قول الأطباء، كان معتوهاً مغروراً فكذلك من نظر إلى المقرين بالآخرة،
والمصدقين بها، وجدهم أعلى الناس رتبةً، في العقل والمعارف. ووجد المكذبين
بالآخرة، أخس الناس، من البطالين، الذين غلبت عليهم الشهوات البهيمية.
فكما أن قول المعتوه، لا يزيل ثقة القلب، بما اتفق عليه الأطباء فكذلك قول
هؤلاء البطالين، الذين بقوا محبوسين، في مدركات الحواس، لا يشكك في قول
الأنبياء والعلماء.
الباب الثالث
فضل الكتابة
اعلموا: أنه تقرر: أن الإنسان مدني بالطبع إذ الإنسان الواحد لو
لم يكن في الوجود، إلا هو، وإلا لأمور الموجودة في الطبيعة، لهلك الإنسان،
أو ساءت معيشته، فالإنسان محتاج إلى أمور، زائدة عما في الطبيعة، مثل
الغذاء المصنوع فإن الأغذية، لا تلائم الإنسان، والملابس، لا تصلح له، إلا
إذا صارت صناعية، فلذلك، يحتاج الإنسان إلى جملة من الصناعات، حتى تسهل
أسباب معيشته. والإنسان الواحد لا يمكنه القيام بالصناعات كلها. فلا بد من
المشاركة والاجتماع حتى يخبز هذا لذاك، وينسج ذاك لهذا. وحينئذ، فيحتاج
الإنسان، إلى أن تكون له قدرة، على أن يعرف الآخر. الذي هو شريكه، ما في
نفسه، بعلامة وضعية، وهي إما إشارة، وإما لفظ، وإما كتابة، والإشارة،
تتوقف على المشاهدة واللفظ، يتوقف على حضور المخاطب وسماعه، وأما الخط فلا
يتوقف على شيء، فهو أشرفها، وهو خاصية النوع الإنساني فاللفظ، أشرف من
الإشارة، والكتابة، أفضل من النطق، لأن الإشارة لا تصلح، إلا للشيء المرئي
الحاضر، وهي عبارة عن تحريك الحدقة إلى جانب العين، فالإشارة نوع واحد من
أو نوعان فلا تصلح لتعريف الأشياء المختلفة، وأيضاً، إذا أشير إلى شيء،
فلذلك الشيء، ذات، قامت بها صفات كثيرة، فلا يعرف بسبب تلك الإشارة أن
المراد، تعريف الذات وحدها.
أو الصفة الفلانية، وأما اللفظ، فإنه رافٍ بجميع ذلك لأن اللفظ، يتناول
الموجود والمعدوم، ويتناول ما تصح الإشارة إليه وما لا تصح الإشارة
إليه،يفهم المقصود منه، دون إبهام، والكتابة أشرف، وأنفع، من الإشارة
واللفظ لأن القلم، وإن كان لا ينطق، فإنه يسمع أهل المشرق وأهل المغرب فما
جمعت العلوم، ولا قيدت الحكمة، ولا ضبطت أخبار الأولين، ومقالاتهم، ولا
كتب الله المنزلة، إلا بالكتابة، ولولا الكتابة، ما استقام للناس دين ولا
دنيا. فالكتابة عين العيون بها يبصر الشاهد الغائب وفي الكتابة، تعبير عن
الضمير، بما لا ينطق به اللسان. ولذا قيل: القلم أحد اللسانين. بل
الكتابة، أبلغ من اللسان، فإن الإنسان، بقدر على كتابة، ما لا يقدر أن
يخاطب به غيره. ويبلغ المقصود، حيث لا يمكن الكلام مشافهةً. ولهذا، نهى
شرع الإسلام، عن تعليم النساء الكتابة، لأن المرأة، قد لا يمكنها لقاء من
تهوى، فتكتب له. فتكون الكتابة، سبباً للفتنة، ومن المعلوم، أن البيان،
بيانان اثنان: بيان اللسان، وبيان البنان. ومن فضل بيان البنان، أن ما
تثبته الأقلام، باقٍ مع الأيام. وبيان اللسان، تدرسه الأعوام. وقوام الدين
والدنيا، بشيئين: السيف والقلم، والسيف تحت القلم. ولله در من قال:
كذا قضى الله للأقلام مذ بُريتأن السيوفَ لها مذ أُرهفت خَدَمُ
وقد قدمنا: أن الملكات الصناعية، تُفيد عقلاً زائداً. والكتابة، من بين الصنائع، أكثر إفادةً لذلك. لأنها تشتمل على علوم وأنظار. إذ فيها، انتقال من صور الحروف الخطية، إلى الكلمات اللفظية. ومنها، إلى المعاني. فهو ينتقل من دليل إلى دليل. وتتعود النفوس ذلك دائماً، فيحصل لها مَلَكة الانتقال، من الدليل، إلى المدلول. وهو مقتضى النظر العقلي، الذي يكتسب به العلوم المجهولة. فيحصل بذلك، مزيد عقل، وزيادة فطنة. والكتابة - وإن عظمت منفعتها - فهي مفرَّعة عن النطق. ولكن، قد يوجد في الفرع، ما لا يوجد في الأصل. فيكون في الفرع، ما في الأصل، وزيادة. بيانه: أن بدن الإنسان، لا يتم إلا بالقلب، الذي هو معدن الحرارة الطبيعية. ولا بد من وصول النسيم البارد إليه، ساعةً بعد ساعة، حتى يبقى على اعتداله. ولا يحترق. فخُلقت الآلات في بدنه، بحيث يقدر الإنسان بها، إلي إدخال النسيم البارد، في قلبه. فإذا مكث ذلك النسيم لحظة، تسخن وفسد. فلزم إخراجه. فالصانع الحكيم، جعل النفس الخارج، سبباً لحدوث الصوت. ثم، إن الصوت، سهل تقطيعه، في المحابس المختلفة، فحصلت هيئات مخصوصة، بسبب تقطيع، ذلك الصوت، في تلك المحابس. وتلك الهيئات المخصوصة، هي الحروف. ثم ركَّبوا الحروف، فحصلت الكلماتُ. ثم جعلوا كل كلمةٍ مخصوصةٍ، معرفةً لمعنى مخصوص. ثم اضطروا إلى الكتابة، وعظمت الحاجةُ إليها. وظاهرٌ أن إدخالها في الوجود، صعب. وذلك، أَنَّا لو افتقرنا، إلى أن نضع، لتعريف كل معنى من المعاني، نقشاً مخصوصاً، لافتقرنا إلى وَضع نقوش لا نهاية لها، قد بروا فيه طريقاً لطيفاً. وهو أنهم وضعوا، بإزاء كل واحد من الحروف النطقية البسيطة، نقشاً خاصاً. ثم جعلوا النقوش المركبة، في مقابلة الحروف المركبة، فسهلت الكتابة، بهذا الطريق. فلهذا، كانت الكتابة، مفرَّعةً عن النطق. ولكن حصلت في الكتابة منفعة عظيمة. وهو أن عقل الإنسان الواحد، لا يقدر على استنباط العلوم الكثيرة، فصار الإنسان، إذا استنبط مقداراً من العلم، أثبته بالكتابة. فإذا جاء إنسان آخر، ووقف عليه، قدر على استنباط شيء آخر، زائد على ذلك الأول، فظهر أن العلوم، إِنما كثُرت، بإعانة الكتابة.
كتابات الأمم
جميع كتابات الأمم، من سكان المشرق والمغرب، اثنتا عشرة كتابة. وهي: الفارسية، والحميرية، والعربية، واليونانية، والسريانية، والعبرانية، والرومية، والقبطية، والبربرية، والأندلسية، والهندية، والصينية. وخمس من هذه، بطل استعمالها. ولم يبق من يعرفها من الأمم. وهي: الحميرية، واليونانية، والقبطية، والبربرية، والأندلسية. والباقيات، مستعملات في بلدانها. أما الكتابة الفارسية، فإنه، وإن كان جنسها واحداً، ففيها ستة أنواع من الخطوط. وحروفها، مركبة من: أجد، هوز، كلمن، سفارش، تخذغ فالثاء المثلثة، والحاء المهملة، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والعين المهملة، والقاف: سواقط عندهم وأول من وضع الكتابة الفارسية، كهمورث. ويقال: كيومرث، ثالث ملوك الفُرْس الأولى. ويقال: إنه أول من تكلم بالفارسية. وقيل: أول من كتب بالفارسية، الضحاك. وقيل: فريدون.وملوك الفرس، طبقتان. فعدة الطبقة الأولى، تسعة عشرة ملكاً، منهم امرأتان. أخرهم: دارا بن دارا، الذي قتله الإسكندر اليوناني. ودثرت الفُرس الأولى، كدثور الأمم الماضية. وعدد ملوك الفُرس الثانية، ثلاثون ملكاً، منهم امرأتان أولهم أردشير بن بابك بن ساسان، الذي وُضع له النرد. وآخرهم، يزدجر بن شهريار. وهم الأكاسرة.
وأصح ما قيل، في مدة الفرس، من ابتداء ملك كهمورث ابن أميم، إلى انقضاء ملكهم من الأرض، ثلاثة آلاف سنة، ومائة سنة، وأربع وستون سنة. وانقضى ملكهم، بقتل يزدجرد ابن شهريار، في خلافة عثمان بن عفان، سنة اثنين وثلاثين من الهجرة. وكانت الفُرس، قليلة الكتب والرسائل. ولم يكن لهم اقتدار، على بسط الكلام، وإخراج المعاني من النفوس، إلى أن ملَكَ زرادشت، صاحبُ شريعة المجوس. وأظهر كتابه العجيب، بجميع اللغات. وألزم الناس، بتعليم الخط والكتابة، فمهروا في ذلك.
ولغات أهل فارس، في القديم، خمس: الفهلوية، والدرية، والفارسية،
والخوزية، والسريانية. أما الفهلوية، فمنسوبة إلى فهلة اسم يقع على خمسة
بلدان. وهي: أصبهان، والري، وهمدان، ونهاوند، وأذربيجان. وأما الدرية،
فمنسوبة إلى دار الملك. وهي لغة أهل المدائن. وبها كان يتكلم، من بدار
الملك. وأما الفارسية، فيتكلم بها الموابذة والعلماء، وهي لغة أهل فارس.
وأما الخوزية، فبها كان يتكلم الملوك والأشراف، في الخلوة، مع حاشيتهم
وأصحابهم وأما السريانية، فكان يتكلم بها أهل السواد، إلا أنها سريانية
غير فصيحة.
وأما الكتابة العربية، فالصحيح، أن أول من خط بالعربي، مُرامر بن مرة.
وكان يسكن الأنبار، ومن الأنبار انتشرت الكتابة في العرب. وأصل الخط
العربي، هو الخط الكوفي. والنقط، حادث في الخط العربي. حدث بعد الإسلام.
والذي نقل الكتابة، من الأنبار إلى الحجاز، حربُ بعد أمية، جد الملوك
الأموية. وهذه الطريقة، الموجودة الآن، أخرجها من خط الكوفيين، وأبرزها في
هذه الصورة، أبو علي محمد بن مقلة، وزير المقتدر بالله العباسي. ثم جاء
بعده، أبو الحسن علي بن هلال، المعروف بابن البواب، فهذب هذه الطريقة،
وكساها طُلاوةً وبهجةً. وهذه الكتابة العربية، قريبة الحدوث. لأن العرب
كانوا أهل حفظ ورواية. أغناهم حفظهم عن الكتابة وكانت أشعارهم هي دواوين
تواريخهم، وضابطة لأيامهم وحروبهم ولم يكن فيها عالم معروف، ولا حكيم
مذكور.
وأما الكتابة الحميرية، فقد قدمنا أنها درست. وكانت تسمى المسند.
وحروفها، منفصلة. غير متصلة. وكانوا يمنعون العامة من تعلمها. ولا يتعلمها
أحد، إلا بإذن الملك فجاءت ملة الإسلام، وليس بجميع اليمن، من يقرأ ويكتب.
قيل: أول من وضع كتابة المسند وهو حمير، أبو ملوك اليمن وهو سبأ. لأنه لما
أَكثر الغزو، في أقطار الأرض، سموه سبا. وهو الذي ابتنى صقلية، وكثيراً من
مدائن المغرب. ملك المغرب مائة سنة. ووصل ملوك حمير، من جهة المغرب، إلى
طنجة. ومن جهة المشرق، إلى سمرقند. وهي مدينة الصفد. والذي دخلها وهدمها،
شمر بن إفريقيش فسميت شمركند أي شمر أخربها. لأن معنى كند بالفارسي أخر.
ثم إن العرب عرَّبوها، وقالوا سمرقند. ثم ظهر له في بنائها، فبناها. وكتب
على بابها، بالكتابة الحميرية: هذا فعل شمر الأشم، ملك العرب، لا العجم.
فمن بلغ هذا المكان، فهو مثلي. ومن جاوزه فهو أفضل. وآخر ملوك حمير،
ذوجدن. وكانت مدة ملكهم، ألفين وعشرين سنة. ثم ملك اليمن بعدهم من الحبشة،
أربعة. ومن الفرس، ثمانية ثم جاء الإسلام، فصارت لهم. وأما الكتابة
السريانية، فهي ثلاثة أنواع: وأقدم الأنواع عندهم، لا فرق بينه وبين
العربي في الهجاء، إلا أن الثاء المثلثة، والخاء، والذال، والصاد، والضاد،
والعين، كلها، سواقط عندهم. وكذا لا ألف. وتركيب حروفها، من اليمين، إلى
اليسار. وبالسريانية، كان يكتب الكلدانيون. ومعنى الكلدانيين، الموحدون.
وهم أمة قديمة، مسكنهم العراق، وجزيرة العرب. منهم النماردة، ملوك الأرض
بعد الطوفان. ولغة السريانية الفصيحة، شأنها عجيب. لأن الكلام فيها، يتركب
من الحروف الهجائية. فكل حرف هجاء، في السريانية، يدل على معنى مفيد. فإذا
جمع إلى مفيد آخر، حصلت منهما، فائدة الكلام وتختلف معاني الحروف، باختلاف
الحركات والسكون. والكلام، في كل لغة، غير السريانية، يتركب من الكلمات،
لا من الحروف الهجائية. وكانت اللغة السريانية، صافيةً، من آدم، إلى
إدريس. وهو الملقب بهرمس الهرامسة، والمثلث بالنعمة، لأنه كان: نبياً،
ملكاً، حكيماً. وهو باني الأهرام، بمصر، على الصحيح وهو أول من تكلم في
الأجرام العلوية، والحركات النجومية، وأول من نظر في الطب، وألف في
البسائط والمركبات. وأول من وضع الهندسة فلما ذهب إدريس، وقع التبديل
والتغيير، في اللغة السريانية، وجعل الناس ينقلونها عن أصلها، ويستنبطون
منها لغاتهم. وأول لغة، استنبطت من السريانية، لغة الهند. فهي أقرب اللغات
إلى السريانية. ولهذا كانت السريانية، ضاربةً في جميع اللغات، سريان الماء
في العود، لأن حروف الهجاء، في كل كلمة من كل لغة، قد فسرت في السريانية،
ووضعت لمعانيها الخاصة. مثاله: أحمد يدل في اللغة العربية، إذا كان علماً،
على الذات المسماة به. وفي اللغة السريانية، تدل الهمزة المفتوحة، التي في
أوله، على معنىً. والحاء المسكنة على معنى، والميم المفتوحة على معنى
والدال إن كان مضمومة على معنى. وإن كانت مفتوحة، على معنى. وإن كانت
مكسورة، على معنى. وهكذا، كل كلمةٍ، مثل زيد وعمرو ورجل وامرأة. والفار
قليط، صار في اللغة العربية، علماً على: محمد بن عبد الله. وفي السريانية،
كل حرف من حروف هذه الكلمة، يدل على معنى، إلى آخر حروفه.
وأما الكتابة العبرانية، فهي من أبجد إلى آخر قرشت وما بعده، سواقط. وهي
مأخوذة من السريانية. ومنسوبة إلى عابر بن شامخ، واضعها.
وأما الكتابة الرومية المطينية، فأول من اخترع حروف اللسان اللطيني،
وأثبتها: كرمنش بن مرسية بن شمس بن مزكية ولم تكن قبله. وذلك، بعد أربعة
آلاف وخمسين من مبدأ الخليقة، أخذها من كتابة اليونان واليونان، أخذوا
كتابتهم، من أهل صور. وأهل صور إحدى مدائن الشام القديمة اخترعوا الكتابة.
وهي التي كانت منشأ للحروف اليونانية. ومن كتابة اليونان، أخذ اللطينيون
كتابتهم، التي هي كتابة جميع أهل أوروبا، مع بعض اختلاف. وقد اندرست
الكتابة اليونانية.
وقل اليونان والروم، من اليسار، إلى اليمين، مرتب على ترتيب حروف أبجد وحروفهم: أبج وزطى كلمن سعفظ قرشت ثخ صغ. فالدال والهاء والحاء والذال والضاد ولا ألف سواقط. والسبب، الذي من أجله يكتبون، من اليسار إلى اليمين أنهم يقولون: إن شأن الجالس، أن يستقبل المشرق، لأنه مطلع النيرات، ومحل ظهور النور. فإذا توجه إلى المشرقي، يكون الشمال على اليسار. فإذا كان كذلك، فاليسار يعطي اليمين القوة وسبب آخر: وهو أن حركة الأعضاء، من استمداد الكبد. والكبد، يستمد من القلب. والقلب، من جهة اليسار. فطريق الكتابة، أن يبتدأ من الجهة، التي منها الاستمداد.
تنبيه الحروف العربية
حروف الكتابة العربية، أكثر من حروف جميع كتابات الأمم. فإنها ثمانية وعشرون حرفاً. وهي: أبجد، هوز، حطي كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ. ويعبرون عنها بأبجد. وهي عبارة عن ثمان كلمات مشهورة، مفتتحة بهذه الكلمة، جمع فيها جميع حروف الكتابة العربية، بلا تكرير. وقد جرت العادة، بتعليمها المبتدئين، بعدما علموهم حروف الهجاء، مفرداتها ومركباتها الثنائية، على ترتيب مألوف للطباع، منشط لهم، على أخذه وضبطه. والفائدة في ذلك، هو التنبيه للمبتدئ، بعد تعلمه المفردات والثنائيات، أن في الكلام، تركيبات ثلاثيات ورباعيات، غير منتظمة على نظم مألوف، ليستأنس بوقوع المخالفة بين الحروف، فيسهل عليه الشروع في الكلام المطلق.وفيه فائدة أخرى. وهي إيناس المبتدئين، بألفاظ مستعملة، في معنى من المعاني، بعدما كانوا يستعملون تركيبات من الحروف مهملة، لا معنى لها. ويؤيد هذا، أن معنى أبجد، أخذ. ومعنى هوز، ركب. ومعنى حطي، وقف علي المقصود. ومعنى كلمن، صار متكلماً. ومعنى سعفص، أسرع في التعلم. ومعنى قرشت، أخذه بالقلب، ومعنى ثخذ، حفظ. ومعنى ضظغ، أتم. وتكون كلها، على صفة الماضي، من الثلاثي أو الرباعي. فمعنى المجموع على ترتيبها: أخذ، ركب، وقف على المقصود، صارم متكلماً، أسرع في التعلم، أخذه بالقلب، حفظ، أتم. وعلى هذا، يمكن اعتبار فائدة أخرى فيها، وهي تأليف المبتدئين بالمعاني المربوطة، بعضها ببعض، بنوع من الارتباط، ليتفطّن المتعلم الذكي - إذا عرفها - إلى أن الأهم له، اللائق به، في حال التعلم، ما يُفهم من هذه الكلمات، من: الأخذ، والتركيب، والوقوف على المقصود، وتكرار التكلم، والإسراع في التعلم، والإقبال عليه بالقلب، وحفظه له، والقيام بحق من الإتمام، وغيره.
وأما قول صاحب القاموس: وأبجد إلى قرشت، وكلمن رئيسهم، ملوك مدين. وضعوا الكتابة العربية، على عدد حروف أسمائهم، هلكوا يوم الظلَّة.. إلى أن قال: ثم وجدوا بعدهم: ثخذ ضظغ، فسموها الروادف!! فهو قول غريب، من صاحب القاموس، بعيد عن الصواب، لا تخفى غرابته، من وجوهٍ كثيرة. وهذه الكلمات الثمانية، فرَّعوا عليها، من قديم الزمان، الحساب المشهور بالجمل بضم الجيم، وفتح الميم، فإن جميع حروف الهجاء، المجموعة فيها، ثمانية وعشرون حرفاً. فجعلوا سبعة وعشرين حرفاً منها، لأصول مراتب الأعداد، من الآحاد والعشرات والمئات. وواحداً للألوف، فلم يحتاجوا - معها - إلى ضم شيء آخر إليها أصلاً عن تكرارها، كلما احتاج أهل الهند، في أرقام حسابهم، إلى ضم علامة صفر إلى عشراتهم، وصفرين في مئاتهم، وثلاثة في آحاد الآلاف وهكذا. فيحصل المقصود، في جميع المراتب، من نفس هذه الحروف، بالإفراد والتركيب والتقديم والتأخير، كما هو مقرر معروف.
خاتمة التأليف والتصنيف
من الناس، من ينكر التأليف والتصنيف وكتابة العلوم، في هذا الزمن. وهذا الإنكار، خطأ. إذ لا وجه لإنكار التصنيف، إذا صدر من العلماء الكاملين، البالغين، مرتبة التصنيف. وإنما يحمل هذا المنكر على إنكاره، التنافس والحسد، الجاري بين كل متعاصرين. ولله در من قال:
قل لمن لا يرى للمعاصر شيئاً ... ويرى للأوائل التقديما
إن ذا القديم كان حديثاً ... وسيبقى هذا الحديث قديما
فإن نتائج الأفكار، لا تقف عند حد. وتصرفات العقول، لا نهاية
لها. لأن العالم المعنويَّ، واسع، كالبحر الزاخر. والفيض الإلهي، ليس له
انقطاع، ولا آخر. وغير محال، ولا مستبعدٍ، أن يدخر الله لبعض المتأخرين،
ما لم يعطه، لكثير من المتقدمين. فقول القائل: ما ترك الأول للآخر شيئاً،
خطأ. والقول الصحيح، هو: كم ترك الأول للآخر. ويقال: لا كلمة أضرُّ
بالعلم، من قولهم: ما ترك الأول للآخر شيئاً، لأن هذه الكلمة، تقطع الآمال
عن زيادة العلم، على علم المتقدمين. ويقتصر الآخر، على ما قدمه الأول، وهو
خطر عظيم، وقول سقيم. فالأوائل، فازا باستخراج الأصول، وتمهيد القواعد،
والأواخر، بالاستنباط من الأصول، وتشييد تلك القواعد، وزيادة البناء
عليها. وإن تصانيف العلوم، كثيرة، لاختلاف أغراض المصنفين. وهي تنحصر، من
جهة المقدار، في ثلاثة أصناف.
الأول: مختصرات، تجعل تذكرة، لرؤوس المسائل. ينتفع بها المنتهي،
للاستحضار. وربما أفادت بعض المبتدئين الأذكياء. والثاني: مبسوطات، تقابل
المختصرات. وهي ينتفع بها للطالعة. والثالث: متوسطات، ونفعها عام.
والتصنيف، على سبعة أقسام. لا يصنف عالم عاقل، إلا فيها. وهي: إما شيء لم
يسبق إليه، فيخترعه. أون شيء ناقص، فيتمه. أون شيء مغلق، يشرحه ويبينه. أو
شيء طويل، يختصره دون أن ينقص شيئاً من معانية. أو شيء متفرق، يجمعه. أو
شيء مختلط، يرتبه. أو شيء أخطأ فيه مؤلفة، فيصلحه.
ويشترط في التصنيف، إتمام الغرض، الذي وضع الكتاب لأجله، من غير زيادة ولا
نقص. وعدم استعمال اللفظ الغريب، إلا في الرموز والألغاز. وينبغي أن يكون
التصنيف، مسوقاً، على حسب إدراك أهل الزمن وعلى قدر ما تصل إليه عقولهم.
فإذا كانت الخواطر ثاقبة، قام الاختصار لها، مقام الإكثار. واستغنت
بالتلويح، عن التصريح. وإلا تكن الخواطر كذلك، فلا بد لها، من زيادة الكشف
والبيان.
وقد جرت عادة المصنفين: أن يذكروا في صدور كتبهم، أشياء سموها الرؤوس.
منها: الغرض، والباعث الذي وقع التصنيف لأجله. ومنها، المنفعة، ليتشوق
الطالب، الناظر في التأليف، إليها. ومنها: العنوان، الدال على ما يأتي
تفصيله. ومنها، تسمية المؤلف نفسه، ليعلم قدره في العلم... وغير هذا.
والمصنفون، على فرق. ومنهم: من له - في العلم - ملكة تامة، ودراية كاملة،
وفهم ثاقب. فتصنيف هذه الفرقة، عن قوة بصيرة، ونفاذ فكر، وسداد رأي.
ومنهم: من له ذهن ثاقب، وعبارة سهلة، طالع الكتب، فاستخرج دررها، وأحسن
نظمها. وهذه، ينتفع به المبتدئون والمتوسطون. ومنهم، من صنف وجمع، ليفيد
نفسه، لا لإفادة غيره. وهذه، لا حجرَ عليه. و ويلزم كل مصنف - إذا تمم ما
صنعه - أن لا يخرجه للناس، ولا يطرحه من يده، إلا بعد تهذيبه، وتنقيحه،
وإعادة مطالعته. فإنه قد قيل: الإنسان في سعة، وفي سلامة، من أفواه جنسه،،
ما لم يصنف كتاباً، أو يقل شعراً. ويقال: من ألف، فقد استشرف أي مد عنقه
للمدح أو الذم، فإن أحسن، فقد استعطف، أي عطفت عليه القلوب، وإن أساء، فقد
استقذف أي عرض نفسه للقذف والشتم.
والعلم، إذا أراد تصنيف كتاب، بغير لغته، وبغير خطه، الذي نشأ
عليهما، وسبقت ملكتهما إليه، ربما كان ذلك عسيراً، في غاية الصعوبة. إني
لأتعجب - وما تقضى عجبي - من علماء فرنسا، وقدرتهم على هذا. فإن الله خصهم
بمزيد ذكاء وفطنة. لأن مباحث العلوم، إنما هي في المعاني. ولا بد، في
اقتناص المعاني، من الألفاظ، من معرفة دلالتها اللفظية والخطية عليها.
وإذا كانت الملكة في الدلالة، راسخةً، بحيث تتبادر المعاني إلى الذهن، من
الألفاظ، زال الحجاب، بين المعانية والفهم. ولم يبق، إلا معاناة ما في
المعاني من المباحث. هذا شأن المعاني مع الألفاظ والخط بالنسبة إلى كل
لغة. فثبت أن اللغة، ملكة في اللسان، والخط، صناعة، ملكتها في اليد. فإذا
تقدمت في اللسان، ملكة العجمة، السابقة. وفي اليد، ملكة غير الخط العربي،
صار مقصراً في اللغة والخط العربيين. لأن الملكة، إذا تقدمت في صناعة، قل
أن يجد صاحبها ملكةً، في صناعة أخرى، إلا أن تكون ملكة العجمة السابقة، لم
تستحكم، كما في الأصاغر، من أبناء العرب والعجم. وكان علماء الملة
الإسلامية، في صدر الإسلام، غير مشتغلين بالتصنيف، جارين على طريقة العرب
الأول، للاستغناء بالحفظ. وكانا يقولون: إذا كتبنا، اعتمدنا على الكتابة،
وتركنا الحفظ، فيعرض للكتاب عارض، فيتلف علمهم بتلف الكتاب. ويقولن أيضاً:
الكتاب، يمكن أن يزداد، وينقص منه، ويغير. والذي يحفظ، لا يمكن تغييره.
ويحكى في هذا المعنى، حكاية وقعت في زمن المأمون العباسي. وذلك أنه جاءه
يهودي يوماً، على أنه يشتكي، من مظلمة ظُلمها. فلما تكلم اليهودي، تعجب
المأمون من فصاحته وبلاغته، وقوة قلبه، وظرافته، ولطافته. فعرض عليه
الإسلام، فامتنع. ثم بعد سنتين جاء مسلماً إلى المأمون!!فسأله عن سبب
إسلامه؟! فقال له: إني لما ذهبت من عندك، قلت في نفسي: أختبر الأديان.
فعمدت إلى التوراة، فكتبت منه عدة نسخ. فقدمت بعض الكلمات، وأخرت البعض،
وأسقطت البعض... وذهبت بالنسخ، إلى مجمع أحبار اليهود، فتساقطوا على
النسخ، واشتروها. ثم عمدت إلى الإنجيل، وعملت به، ما عملت بالتوراة وذهبت
بالنسخ إلى مجمع القسيسين، فتساقطوا على النسخ واشتروها. ثم عمدت إلى
القرآن. وفعلت به، ما فعلت بالتوراة والإنجيل، وذهبت بالنسخ إلى مجمع
العلماء، فصار كل من يتصفح النسخ، وينظر فيها، يقول: هذا ما هو القرآن،
ويرميها. فعملت: أن الكتب المنزلة - كلها - تقبل التبديل والتغيير، إلا
القرآن، لكونه محفوظاً في صدور أهله، فأسلمت لهذا السبب.
ثم، انتشر الإسلام، واتسعت مملكته، وحدثت الفتن، شرعوا في تدوين الحديث
النبوي، وقوانين الشريعة. واشتغلوا: بالنظر، والاستدلال، والاستنباط،
وتمهيد القواعد والأصول، وترتيب الفوائد والفصول. وكان ذلك، مصلحة عظيمة.
ومع هذا، فالسند عند علماء الإسلام، شرط في العمل بما في الكتب، والاحتجاج
بها، والسند: هو أن يعطى المصنف، كتابه إلى آخر، ويقول له: أذنت لك، أن
تروي عني هذا الكتاب. ويعطيه الذي أخذه عن المصنف، إلى آخر - بهذا الشرط -
وهكذا نسبة كل علم، وإذا عدم هذا السند في كتاب، يكون غير معتبر، ولو تكون
فيه العلوم الكثيرة. ولا يصح نسبة ما في الكتاب، إلى من نسب إليه الكتاب،
إلا بشرط السند. وهذا، شيء خص به علماء الإسلام وشريعته. فإن أحاديث رسول
الله صلى الله عليه وسلم، رواها عنه العدول. ثم أخذها، عن أولئك العدول،
عدولٌ آخرون... وهكذا. حتى وصلت للبخاري مثلاً، وهو عدل، ثم البخاري، صنف
كتابه، ورواه عنه تسعون ألفاً، ثم انتشر في المشرق والمغرب، بالسند، حتى
وصل إلينا.
وأما علوم الأوائل والفلاسفة، فإنها كانت، في صدر الإسلام، مهجورةً إلى دولة بني العباس. وكان أول من اعتنى منهم بالعلوم: أبو جعفر المنصور. وكان مقدماً في علم الفلسفة والنجوم. ثم لما وصلت الخلافة إلى المأمون بن الرشيد، تمم ما بدأ به جد. واستخرج العلم، من معادنه، بعلو همته. فراسل ملوك الروم، وسألهم كتب الفلاسفة؟؟ فبعثوا إليه من كتب: أفلاطون، وأرسطو، وبقراط، وجالينوس، وأقليدس، وبطليموس... وغيرهم. وأحضر - لهذه الكتب - مهرة المترجمين، فترجموا له، على غاية ما أمكن. ثم ألزم الناس قراءًتها، ورغبهم في تعلمها. إذ المقصود من المنع منها، في صدر الإسلام، هو لأجل ضبط قواعد الشريعة، ورسوخ العقائد الصحيحة. وقد حصل ذلك. مع إن أكثر الفلسفة، والهيئة، والهندسة، لا تعلق لها بالديانات. ولما نقلت علوم الأمم، بالترجمة. وحدثت الملكات. لأهل الملة الإسلامية، نقلوا هذه العلوم إلى علومهم. وبقيت تلك الدفاتر، التي باللغة الأعجمية نسياً منسياً. وأصبحت العلوم - كلها - بلغة العرب. واحتاج القائمون بها، إلى معرفة الدلالات اللفظية، والخطية، في لسانهم، دون ما سواه من الألسن، لدروسها، وذهاب العناية بها.
خاتمة الرسالة
في انقسام الناس بحسب العلوم والمعارف واختلاف المذاهب اعلموا: أن الناس قسمان: قسم اعتنى بالعلوم، فظهرت منهم أنواع المعارف، فهم صفوة الله من خلقه. وقسم لم يعتن بالعوم، عناية يستحق بها اسمه. فالأول، أمم. منهم: الهند، والفرس، واليونان، والروم، والإفرنج، والعرب، والعبرانيون، وأهل مصر، والثاني: بقية الأمم. أما الهند، فإن أهله - وإن كانوا في أول مراتب السواد - فإن الله، جنبهم سوء أخلاق السودان. وفضلهم على كثير من البيض. فهم أهل الآراء الفاضلة، والأحلام الراجحة. ولهم التحقيق، في علم العدد، والهندسة، والطب، والنجوم، والعلم الطبيعي. ومنهم براهمة - فرقة قليلة العدد - مذهبهم: إبطال النبوات، وتحريم ذبح الحيوان. وهذا، من ضعف أمزجتهم وقلوبهم. فإن قوي القلب، بحسب المزاج، يستحسن الإيلام، ولا يستقبحه. وجمهور الهند: صابئة، يعبدون الملائكة والكواكب وهم ينكرون النبوات أيضاً. ولهم في تعظيم الكواكب وأدوارها، آراء ومذاهب. والمشهور في كتبهم، مذهب السند هند أي في دهر الداهر ومذهب الأرجهير، ومذهب الاركند. ولهم في الحساب والأخلاق والموسيقي، تأليفات كثيرة. ومن تصنيف حكماء الهند: كتاب كليلة ودمنة. وما فيه من الحكم، المنظومة بضرب الأمثال، يشهد بكمال عقل واضعه. وترجم من الهندسة إلى الفارسية، أيام أنو شروان، الملك العادل وكان محباً في العلم وأهله ثم تُرجم، من الفارسية إلى العربية، أيام المنصور العباسي. ترجمه ابن المقفع، العالم المشهور.ويكفي أهل الهند شرفاً، وضع الشطرنج، الذي سار في الدنيا سير الشمس. وسار الناس، يشهدن بالعقل لمن يحسن اللعب به، فكيف بعقل واضعه ومستنبطه؟! واسم واضعه: صصه بن داهر واسم الملك، الذي وضع لأجله شهرام. وكان أردشير بن بابك، أول ملوك الفرس الأخيرة، وضع النرد وافتخرت الفرس به. فلما وضع صصه بن داهرالشطرنج حكمت حكماء ذلك العصر، بترجيحه على النرد. ولما عرضه على الملك شهرام أعجبه، وفرح به كثيراً. وقال لصصه اطلب مني ما تريد من الأموال!؟ فقال له: طلبتُ أن تضع حبة قمح، في البيت الأول. ولا تزال تضاعفها، حتى تنتهي، إلى الآخر. فمهما بلغ من القمح، تعطيني. فاستصغر الملك ذلك. وأنكر عليه، لكونه طلب شيئاً حقيراً، عند الملك!!وكان أضمر له شيئاً كثيراً. فقال صصه ما أريد إلا هذا؟ فرادَّه فيه، وهو مصمم عليه، فأجابه الملك إلى مطلوبه، فلما قيل لأرباب الأقلام، حسبوه فقالوا: ما عندنا قمح يفي بهذا، ولا بما يقاربه. فلما أُخبر الملك، استنكر هذه المقالة، وأحضر أرباب الديوان، وسألهم؟ فقالوا له: لو جمع كل قمح في الدنيا ما بلغ هذا القدر!!فطالبهم ببيانه، فقعدوا له، وحسبوه، فظهر له صدقُ ذلك. فقال الملك لصصه: أنت في طلبتك، أعجبت حالاً، من وضعك الشطرنج.
ومن تأمل الشطرنج، وتأمل حركات قطعه، وتفكره في صورة وضعه، وجده
قد كشف، عن سر من سر القضاء والقدر، بسهولة. وذلك: أن الواضع له، حكيم
فيما رتبه وقرره. ألهمه - تعالى - ما قضاه في أزله، وسبق به علمه، وجرى
بوضعه قدره!! ولذلك، لم يشاركه، في اختراعه له، مشارك. وجعل أمر كل لاعب
به، من الناس، راجعاً إليه، وعائداً عليه إن غلبَ، فباجتهاده. وإن غُلب،
فبتفريطه. وإن اللاعِبَيْن - كليهما - مع تفويض الأمر إليهما، في الجد
والاجتهاد والفكر والتدبير والاكتساب والتحيل، لا يخرجان في جميع ذلك، عما
قضاه الواضع، وقدره، وشرعه لهما. فهما مجبوران، في صورة مختارين.
ومختاران، في صورة مجبورين. اطلع هذا الواضع، على سر عزيزٍ، من أسرار قدر
الله - تعالى - وعلم أن الإنسان كاسب غانم، أو معاقب. وأن الله لا يظلم
مثقال ذرة " ولكن الناس أنفسهم يظلمون " ، وأن الله أراد من العباد، ما هم
فاعلون له، ولم يجبرهم. ولو عصمهم، ما خالفوه كما أراد الواضع، من
اللاعبين، ما هم لاعبون، ولم يجبرهم فمن أحسن، فلنفسه. " ومن أساء فعليها
" ، ولم يخرج واحد منهما عما قدره من البيوت، والقطع، وعددها، ونقلها. ولو
أراد منهما غير ذلك، ما خالفاه. فافهم هذا جيداً. فالشطرنج، مثال حكمي،
ووضع علمي، يجلب به حسن الرأي، ويزداد به العقل، ويلهى به عن الهم، ويكشف
عن مستور الأخلاق، ويحكي صورة الحرب، ويبين مقدار حلاوة الظفر بالخصم،
والنصر على العدو، ومقدار مرارة القهر والخذْلان.
والشطرنج الكبير، فيه من الزوائد: جملان، وزرافتان، وطليعتان، ودبابتان،
ووزير.
وأما الفرس، فإنهم أمة قديمة، من أقدم أمم العالم، وأشدهم قوةً. واسم
أبيهم بالعربية، فارس. وباليونانية، يرشور. وبالفارسية، يرشيرش. وكانت لهم
دولتان عظيمتان طويلتان. الأولى منهما، الكييه وإنما قيل لهم كييه لأنهم
كانوا يسمون الملك منهم كي فلان ومعناه التنزيه. أي مخلص، متصل
بالروحانية. ويظهر من التواريخ، أن مبدأها، ومبدأ دولة التبابعة ملوك
العرب من حمير، واحد. وهذه الدولة الكييه، التي غلب عليها الإسكندر
اليوناني. والثانية، الساسانية. وهي المعاصرة لدولة الروم بالشام. وهذه
الثانية، هي التي غلب عليها المسلمون.
وكان الفرس، في أول أمرهم موحدين، على دين نوح، إلى زمن طهمورث. وهو أول
من ذلل الخيل، وركبها. فاعتقد دين الصابئين، وقهر الفرس على اتباعه. وبقوا
على هذا الدين، نحو ألف سنة. إلى أن تمجسوا، بسبب زرادشت. وكان ظهوره،
أيام يستاسف أحد ملوكهم. فجاء إلى يستاسف وعرض عليه دينه، فأعجبه، وحمل
الناس على الدخول فيه. وقتل من امتنع. وجاء زرادشت، بكتاب، ادعاه وحياً.
كتبه في اثني عشر ألف جلد!! وسمي ذلك الكتاب سناه ويدور على سنين حرفاً،
من حروف المعجم. وفسره زرادشت. وسمي تفسيره زند ثم فسر التفسير، وسماه زند
وهذه اللفظة، هي التي عربتها العرب، فقالت: زنديق. وكان زرادشت، يقول
بإلهين اثنين: يزدان، وأهرمن أي النور والظلمة ويعبد النار. وكان هذا
الكتاب، ثلاثة أقسام: قسم في أخبار الأمم الماضية، وقسم في حدثان
المستقبل، وقسم في نواميسهم وشرائعهم. وجدد زرادشت بيوت النيران، وكان
أخمدها منوشهر، أحد ملوكهم. ورتب لهم عيدين: النيروزَ في الاعتدال
الربيعي، والمهرجان في الاعتدال الخريفي، ولما غلب الإسكندر الفرس الأولى،
أحرق هذه الكتب.
وبقوا على ذلك، إلى أيام سابور بن أردشير، فظهر ماني الحكيم، بعد المسيح.
وكان ماني يقول: موجد العالم، اثنان: النور، خالق الخير. والظلمة، خالق
الشر، واتبعه سابور قليلاً، ثم رجع إلى المجوسية، دين آبائه.
وفي أيام قباذ، من ملوك الفرس، ظهر مزدك وكان يقول: باستباحة أموال الناس،
وأنها مشتركة بينهم، وليس لواحد ملك شيء، ولا تحجيره، عن غيره. والأشياء -
كلها - من ملك الله، لا يختص أحد بشيء.
وفي أيام أبرويز منهم، وصلت جنود الفرس إلى بيت المقدس، وأخذوا أسقفها،
ومن معه، وطالبوهم بخشبة الصليب، فاستخرجوها من الدفن، وبعثوا بها إلى
أبرويز.
وفي أيام بوران بنت أبرويز ردت خشبة الصليب، إلى الجاثليق. وأمة
الفرس، هم أعدل الأمم، وأوسطهم داراً، بالنسبة إلى هذه المعمورة. ولهم
عنابة بالطب، وأحكام النجوم. ولهم أرصاد، ومذاهب في حركاتها. وأنفق
العلماء. على أنَّ أصح المذاهب، في الأدوار، مذهب الفرس، ومنهم واضع
النرد. جعله مثالاً للدنيا وأهلها، فرتب الرقعة: اثني عشر بيتاً، بعدد
شهور السنة. وجعل القطع، ثلاثين قطعة، بعدد أيام كل شهر. وجعل الفصوص،
مثلاً للقدر، وتقلبه بأهل الدنيا.
وأما اليونانيون، فهم أمة عظيمة القدر. وهم منسوبون إلى يونان. وهو، في
التوراة، ولد يافث بن نوح، لصلبه. واسمه فيها يافان بفاء، تقرب من الواو
فعربته العرب: إلى يونان. وبلادهم: رومة إيلي، وأناطولي، وقرمان. وإخوانهم
اللطينيون، مساكنهم بالمغرب منهم. ومن اليونان، الإسكندر الذي قهر الملوك،
وغلبهم. يقال: إنه استولى على خمسة وثلاثين ملكاً.
ومن اليونان: الحكماء المشهورون، مثل أرسطو وهو معلم الإسكندر. وكان
مسكنه، مدينة أثنيا وهو كبير حكماء الخليقة، من غير منازع. أخذ الحكمة عن،
أفلاطون اليونان كان يعلم الحكمة، وهو ماشٍ، تحت الرواق المظلل له، من حر
الشمس، فسمى تلاميذه بالمشائين، وأخذ أفلاطون، عن سقراط ويعرف بسقراط الدن
بسكناه في دن من الطين اتخذه. وقتله قومه، لما نهاهم، عن عبادة الأوثان.
وكان هو أخذ الحكمة، عن فيثاغورس منهم. ويقال: إن فيثاغورس، أخذ عن تاليس
حكيم ملطية وأخذ تاليس عن لقمان الحكيم المشهور.
ومن حكماء اليونان، ذي مقراطيس، وأنكساغورس وأرسطو، هو الذي ترجم كتب هرمس
المثلث بالنعمة. وأخرجها من اللسان المصري، إلى اليوناني. وشرح ما فيها،
من العلوم والحكمة والطلسمات. وكتاب الأطماطيس يحتوي على فتح المدن
والحصون، بالطلسمات والحكم!! ومنها، طلسمات لإنزال المطر، وجلب المياه،
وكتاب الأشطيرطاش في الاختبار، على سير القمر في المنازل، والاتصالات.
وكتب أخرى، في منافع، وخواص، لأعضاء الحيوانات، والأحجار، والأشجار،
والحشائش...، ومنهم بندقليس وكان في عمر داود النبي وكان علماء اليونان،
يسمون: فلاسفة إلهيين ومعنى فلا بلغتهم، الحب. وسوف العلم فمعنى فيلسوف
محب العلم. ولهم تصانيف، أنواع العلوم. فهم أرفع الناس منزلةً، لما ظهر
منهم من الاعتناء الصحيح، بفنون الحكمة، من العلوم الرياضية، والمنطقية،
والمعارف الطبيعية. وجميع العلوم العقلية، مأخوذة عنهم. وهم الذين أسسوها.
وفي دولة فيلادلفوس أي محب أخيه كانت ترجمة التوراة، وكتب الأنبياء، من
العبرانية إلى اليونانية. ولغة الأقدمين من اليونان، تسمى الإغريقية وهي
من أوسع اللغات. ولغات المتأخرين، تسمى اللطينى، لأن اليونان، فرقتان:
اللطينيون والإغريقيون.
وأما الروم، وهو الكيتم اللطينيون، فهم إخوان يونان. ونسبهم إلى: يافث بن
علجان بن نوح. وبلادهم، بالناحية الغربية من خليج القسطنطينية إلى بلاد
الإفرنك. وملك هذه الأمة، قديم. وأول ملوكهم: القش بن شطرش بن أيوب. وذلك،
في آخر الألف الرابع، من مبدأ الخليقة. ثم اتصل الملك لابنه، ولحافديه:
روملوس وأملش. وهما اللذان اختطا مدينة رومة. وذلك، لأربعة آلاف وخمسمائة،
من مبدأ الخليقة. وسميت باسم بانيها، وسمي أهلها: الروم.
وكان الروم صابئة، إلى أن قام قسطنطين، المتدين بدين المسيح. وقهر الروم
على الدخول فيه، فأطاعوه. ولم يزل دين المسيح يقوى، فلا دخل فيه جميع
الأمم المجاورة للروم إلى أن.
كان منهم حكماء، وعلماء بأنواع الفلسفة. وكثير من الناس يقول: إن
الفلاسفة المشهورين، روميون. الصحيح، أنهم يونانيون. ولتجاوز الأمتين دخل
بعضهم في بعض، واختلط خبرهم. وكلا الأمتين، مشهور العناية بالفلسفة إلا أن
لليونانيين، من المزية والفضل، ما لا ينكر. ولغتهم، مخالفة للغة اليونان.
وقيل: إن لغة اليونان، الإغريقية. ولغة الروم، اللطينية ولهم قلم، يعرف
بالساميا في القديم، ولا نظير له فإن الحرف الواحد منه، يحيط بالمعاني
الكثيرة، ويجمع عدة كلمات. قال جالينوس، في بعض كتبه: كنت في مجلس عام،
فتكلمت في التشريح، كلاماً عاماً. فلما كان بعد أيام، لقيني صديق لي، فقال
لي: إن فلاناً، يحفظ عليك، في مجلسك أنك تكلمت بكذا وكذا. وأعاد علي
ألفاظي. فقلت: من أين له هذا؟! فقال: إنه يعرف قلماً، يسبقك - بالكتابة -
في كلامك. وهذا القلم، يتعلمه الخواص، ويمنع منه سائر الناس، لجلالته.
وأما الفرنج، فهم من ولد يافث بن نوح، كان يافث، ولد سبعة من الولد، منهم
ريعات. ومنه الفرنج، كما في التوراة. ويقال لهم: فرنسوس. وقاعدة بلادهم
أفرنس بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح الراء المهملة وسكون النون وبالسين
المهملة ويقولون: أفرنك على وزن أفرنس وكأن أفرنس معرب من أفرنك ويقولون:
أفرنج والكاف والقاف والجيم تتعاقب في كلام العرب وملكهم، ويقال له:
الفرنسيس وبلادهم، بسائط، على عدوة البحر الرومي، وشماله، وجزيرة الأندلس،
من ورائهم، في الغرب. تفصل بينهم وبينها، جبال متوعرة، ذات مسالك ضيقة،
يسمونها البرث. وسكان تلك الجبال، الجلالقة وهم من شعوب الفرنك وكان
الفرنسيس، استولوا من الجزائر الرحرية، علي: صقلية، وقبرص، وأقريطش وجنوة
واستولوا علي قطعة من بلادهم من الأندلس، إلى برشلونة. وعلى رومة. وكان
الإفرنج أيضاً ملكوا إفريقة، ونزلوا أمصارها العظيمة، مثل: سبيلطه،
وجلولا، ورباغية، ولميس... وغيرها من الأمصار. وغلبوا من كان بها من
البربر، وأدوا إليهم الجباية، وعسكروا معهم، في حروبهم. ولم يكن للروم
فيها ولاية وإنما كان، من كان منهم بإفريقية، جنداً للفرنج، ومن حشدوهم.
وكانوا ملكوا، ما بين طنجة وطرابلس الغرب. ومن الفرنج الملك جرجير الذي
قتله العرب، أول دخولهم إفريقية، سنة 27 من الهجرة. وكان قاعدة ملكه
سبيطلة وهي قبلة القيروان، على مسافة يومين. وكان الفرنج بإفريقية، يؤدون
إلى هرقل، ملك القسطنطينية، لما كان الروم، أغلب على الأمم المجاورة لهم،
من جميع الجهات، إلى أن كان الملك جرجير. فخلع طاعة الروم، وضرب الدراهم
والدنانير على صورته.
ولما دخل العرب إفريقية. وقتلوا الملك جرجير، صار التغلب للبربر
على الفرنج. واجتمع البربر والفرنج، على قتال العرب. وما زالت الحرب
سجالاً بينهم، إلى سنة أربع وثمانين، فانهزم البربر والفرنج، هزيمةً، لم
يقع لهم جمع بعدها. فمن كان من الفرنج، قريباً من البحر، ركب إلى الأندلس،
وإلى صقلية، وإلى سردانية، من الفرنج. الذي كانا بإفريقية، ومن كان بعيداً
من البحر، اختلط مع البربر، وصاروا جملة واحدة وفي جبل أوراس، كثيراً من
الفرنج. ومن تأمل الآن، سكان جبل أوراس، فرق بين البربر والفرنج. ثم اشتغل
العرب، بحرب الفرنج، في الأندلس والجزائر، أيام عبد الرحمن الداخل الأموي،
وبنيه بالأندلس، وعبد الله الشيعي، وبنيه بإفريقية، وملكوا عليهم جزائر
البحر الرومي، إلى أن فشلوا، وركدت ريح الدولتين، وضعف ملك العرب،
فاسترجعوا ما أخذه العرب. ثم استفحل ملك فرانسا، بعد القياصرة الأولى.
وكثرت عندهم العلوم الفلسفية، والمعارف، وتنافسوا في اكتساب الفضائل
السياسية، فلم يبق لليونان والروم ذكر، في هذا الزمان. لا سيما في عقد
الستين، بعد المائتين والألف. فقد جمعوا علوم جميع الأمم، من العرب
والعجم. وتمم الله عليهم النعمة، بسلطنة الملك الشهير العادل، أعلى الملوك
الإفرنجية همة، وأبعدهم صيتاً وأنداهم يداً، وأطولهم سيفاً، نابليون
الثالث. فإنه جمع كلمتهم بعد الشتات، وأحياهم، بعد أن كادوا يصيرون، من
جملة الأموات. ووصل حبلهم بعد البتات وأنامهم في مهد الأمان، بعد أن كانوا
لا يأمنون في بيوتهم، من العدوان وأشاد لهم ذكراً، وإن لم يكونوا خاملين،
إذ بعض الذكر، أنبه من البعض، عند العاقلين. وربحوا في يومه، ما لم يربحوه
في سنة غيره، من الملوك. فله بذلك، منة عظمة عليهم. ولكن لا يشكر النعمة
من الناس، إلا الأكياس.
وأما العرب، فهم من ولد سام بن نوح، وهم الأمة الرحّالة، الخيامُ، لسكناهم
والخيل لركوبهم. والأنعام، لكسبهم. يقومون عليها، ويقتاتون بألبانها،
ويتخذون اللباس والأثاث، من أوبارها وأشعارها. ويحملون أثقالهم على
ظهورها، ويبتغون الرزق - في غالب أحوالهم - من الصيد، وقطع الطرق،
والغارات على من جاورهم من الأمم. ومساكنهم، ما بين المحيط، من المغرب،
إلى أقصى اليمن والهند، من المشرق. وما بين ذلك. كمصر، وصحارى برقة،
وإفريقية، والزاب، والمغرب الأقصى، والسوس. فما انتقلوا، إلا في المائة
الخامسة وكانت لهم دولة عظيمة، وآثاراً كريمة. وصل ملكهم إلىطنجة، من
المغرب. وإلى سمرقد، من المشرق، في الجاهلية. وكانوا في الجاهلية،
أصنافاً: صنفٌ اعترف بالخالق، وأنكر البعث. وصنف عبدوا الأصنام. وصنف
عبدوا الملائكة. وكان منهم من يميل إلى اليهودية ومنهم من يميل إلى
النصرانية ومنهم من يميل إلى الصابئة وكانت بقيت عندهم، بقايا من دين
إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. فكانوا لا ينكحون الأمهات، ولا البنات، ولا
الأخوات، ولا يجمعون بين الأختين. وكانوا يحجون البيت، ويغتسلون من
الجنابة، ويداومون على المضمضة، والاستنشاق، والسواك، والاستنجاء، ونتف
الإبط، وحلق العانة، والختان. ويقطعون يد السارق، ويعطون دية المقتول،
مائةً من الإبل. ويطلقون، وتعتد المرأة، التي مات زوجها، سنة. وكانت
علومهم علم الأنساب، والنجوم، وتعبير الرؤيا ونظم الأشعار، والخطب. وليس
يصل إلى أحد، من أهل المشرق والمغرب، خبر إلا بالعرب. وذلك، أن من سكنوا
مكة، أحاطوا بأخبار أهل الكتابين: التوراة والإنجيل. ومن سكن الحيرة، علم
أخبار فارس ومن سكن الشام، عرف أخبار الروم واليونان وبني إسرائيل. ومن
سكن البحرين، علم أخبار الهند والسند. وكانوا يفتخرون بالبيان في الكلام.
والفصاحة في المنطق، والوفاء بالعهد، وإكرام الضيوف، وعلو الهمة. روي عن
شبيب بن شبة، قال: كنا في مجلس عظيم، فورد علينا ابن المقفع - وكان من
أشراف الفرس وحكمائهم - فقال لنا: من أعقل الأمم؟! فنظر بعضنا إلى بعض،
وقلنا: لعله يميل إلى أصله. فقلنا: الفرس. قال: ليس هناك. ملكوا كثيراً من
الأرض، وحووا عظيماً من الملك، فما استنبطوا بعقولهم شيئاً. فقلنا: الروم.
فقال: أصحاب صنعة. فقلنا الصين. فقال: أصحاب طرفة. فقلنا: الهند. فقال
أصحاب فلسفة. فقلنا: السودان. فقال: أشر خلق الله.
فقلنا: الخزر. فقال: نعم سائمة. فقلنا: فمن؟! قال: العرب!!
فضحكنا!!فقال: ما أردت موافقتكم. ولكن، إذا فاتني حظي من النسب، فلا
يفوتني حظي من المعرفة، إن العرب، حكت على غير مثال. يجود أحدهم بقوته،
ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله، فيكون قدوة.
ويفعله، فيصير حجة. ويحسن ما شاء، فيحسن. ويقبح ما شاء، فيقبح، رفعتهم
عقولهم. وأعزتهم هممهم حتى نالوا أكرم الفخر، وبلغوا أشرف الذكر. فلما
شرفهم الله، بالرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهم على هذه
الأخلاق الجميلة، والفضائل الجليلة، تنافسونا في زيادة الفضائل، وتسابقوا
إلى نيل العلوم والمعارف. فاكتسبوا منها ما لم يكتسبه الأوائل. واثروا
الآثار العظيمة، في أقرب مدة، من بناء المدائن، وعمل القناطر وفتح
الخلجان. فقد أجرى موسى بن نصير، البحر، اثني عشر ميلاً، إلى دار الصناعة
بتونس وصنع مائة مرآب. وغزا صقلية، وأخذها ووصل عمرو بن العاص، بين النيل
وبحر القلزم، في مدة سنة. وجرت فيه السفن، من خلافة عمر بن الخطاب، إلى ما
بعد خلافة عمر بن عبد العزيز. احتفره، من الخليج، الذي في ناحية الفسطاط.
وقال له: خليج أمير المؤمنين. وساقه إلى القلزم. ثم ضيعه الولاة وتُرك،
وغلب عليه الرمل، ونقطع، وصار منتهاه، إلى ذنب التمساح.
وتيسر لهم من التصنيف، في أنواع العلوم، ما لم يتيسر لأحد قبلهم. حتى إن
منهم، من بلغت تصانيفه، في أنواع العلوم: ثلاثة آلاف مصنف، وزيادة، يحكى
أن خزانة الكتب، بمصر، في دولة العبيديين، بلغت ألفي ألف مصنف، وستمائة
ألف مصنف. وفي بعض التصانيف، مائة مجلد، إلى ثلاثمائة مجلد، كتفسير
الرازي، وغيره. وبلغ ملكهم، حيث لم يبلغ ملك أمةٍ قبلهم، من آدم إلى الآن.
ثم بدا فيهم النقص. وغير الله بهم، حيث غيروا ما بأنفسهم، شأن الأمم...
وكل شيءٍ بلغ الحد، انتهى.
إذا ما تم شيء بدا نقصهُ ... فحاذرْ زوالاً إذا قيل: تمَّ
وأما العبرانيون، وهم بنو إسرائيل، عنصر الأنبياء، فكانت عنايتهم بعلوم
الشرائع، وسير الأنبياء. فكان علماؤهم، أعلم الناس، بأخبار الأنبياء، وبدء
الخليقة. لكنهم لم يشتهروا بعلم الفلسفة.
وأما أهل مصر، فهم أخلاط من الأمم. إلا أن أكثرهم، قبط، وإنما اختلطوا،
لكثرة من تداول ملك مصر، من الأمم، كالعمالقة واليونان والروم. فانتسبوا
إلى موضعهم. فكانوا في القديم، صابئة. ثم تنصروا، إلى وقت الإسلام. وكان
لقدمائهم، عناية بأنواع العلوم. ومنهم هرمس. كان قبل الطوفان. وكان بعده
علماء بضروب الفلسفة، وعلم الطلسمات، والمرايا المحرقة، والكيمياء. وكانت
دار العلم بها، مدينة منف فلما بنى الإسكندر مدينة الإسكندرية، رغب الناس
في عمارتها. فكانت دار العلم والحكمة، إلى الفتح الإسلامي.
والسبب الظاهر. بحسب العادة، التي أجراها الله تعالى، وبما دل عليه
الاستقراء، في اختلاف الناس، في عقولهم، وأخلاقهم، ومعارفهم أحوال الشمس
في الحركة. فإن الناس، على ثلاثة أقسام معتبرة، وفي كل قسم، أقسام متقاربة.
أحدها: الذين يسكنون تحت خط الاستواء إلى ما يقرب من المواضع، التي
يحاذيها ممر رأس السرطان. وهؤلاء. أضعف الناس عقلاً، وأوحشهم أخلاقاً،
وأبعدهم عن المعارف العقلية، والكمالات الإنسانية. وأما الذين مساكنهم،
أقرب إلى محاذاة ممر رأس السرطان، فعقولهم أكمل، من الذين قبلهم.
وطبائعهم، معتدلة. وأخلاقهم مؤنسة، كالهند واليمن وبلاد العرب كلها، وبعض
المغاربة.
وأما القسم الثاني، فهم الذين يسكنون، على رأس ممر السرطان، إلى محاذاة
نعش الكبرى. وهم سكان وسط المعمورة، من هذه الأرض. فهم أكمل الناس عقلاً
وألطفهم أذهاناً، كأهل العراق والشام وخراسان وأصبهان وهم مختلفون في
الكمال، وأكملهم عقلاً، وأكثرهم قبولاً للمعارف، سكان الموضع، المعروف
بأيران شهر. ويليهم في الكلال، سكان إفرنس، فإنهم وسطُ الإقليم الخامس،
ويليهم في الكمال، أهل الأندلس، فإن بلادهم، أخذت من الإقليم الخامس
والسادس.
وأما القسم الثالث، من سكان الأرض، فهم الذين مساكنهم، محاذية
لبنات نعش. وهم الروس والصقالبة. فعقولهم ناقصة وأخلاقهم وحشية. وأذهانهم
باردة، بعيدة عن قبول الكمال. وهم متفاوتون في النقصان. فبعضهم أنقص من
بعض. والكمال الحقيقي لله تعالى وحده. وكل كمال، إذا نسب إليه تعالى فهو
نقص.
انتهى ما أوردناه من هذه العجالة.
وكان الفراغ من تسويدها، في يوم الاثنين 14 من رمضان سنة 1271 هجرية
والحمد لله أولاً، وأخراً، وظاهراً وباطناً.