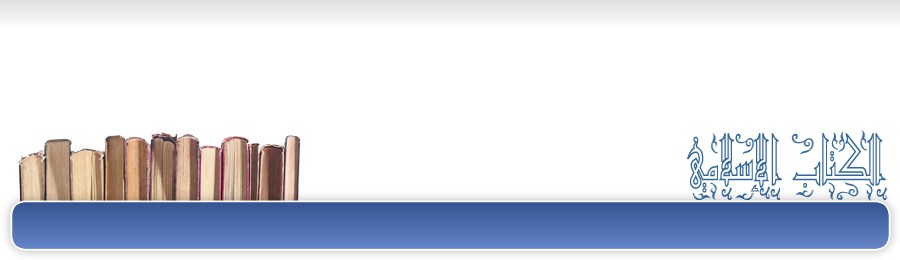كتاب : تهذيب الأخلاق
المؤلف : ابن مسكويه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أرشد إلى الصراط المستقيم ومدح الخلق العظيم وأرسل نبيه محمد متمما لمكارم الأخلاق وأدبه فأحسن تأديبه على الإطلاق.اللهم إنا نتوجه إليك ونسعى نحوك ونجاهد نفوسنا في طاعتك ونركب الصراط المستقيم الذي نهجته لنا إلى مرضاتك فاعن بقوتك واهدنا بعزتك واعصمنا بقدرتك وبلغنا الدرجة العلي برحمتك والسعادة القصوى بجودك ورأفتك إنك على ما تشاء قدير.
قال أحمد بن محمد بن مسكويه غرضنا في هذا الكتاب أن نحصل لأنفسنا خلقا تصدر به عنا الأفعال كلها جميلة وتكون مع ذلك سهلة علينا لا كلفة فيها ولا مشقة ويكون ذلك بصناعة وعلى ترتيب تعليمي والطريق في ذلك أن نعرف أولا نفوسنا ماهي وأي شيء ولأي شيء أوجدت فينا، أعني كمالها وغايتها وما قواها وملكاتها التي إذا استعملناها على ما ينبغي بلغنا بها هذه الرتبة العلية وما الأشياء العائقة لناعنها وما الذي يزكيها فتفلح وما الذي يدسيها فتخيب فإن الله عز من قائل يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاسب من دساها. ولما كان لكل صناعة مباد عليها تبتني وبها تحصل وكانت تلك المبادى مأخوذة من صناعة أخرى وليس في شيء من هذه الصناعات أن تبين مبادى أنفسنا كان لنا عذر واضح في ذكر مبادىء هذه الصناعة على طريق الإجمال والإشارة بالقول الوجيز وأن لم يكن مما قصدنا له واتباعها بعد ذلك بما توخيناه من إصابة الخلق الشريف الذي يشرف شرفا ذاتيا حقيقيا لا على طريق العرض الذي لا ثبات له ولا حقيقة أعني المكتب بالمال والمكاثرة أو السلطان والمغالبة أو الإصطلاح والمواضعة فنقول وبالله التوفيق لوا نبين به إن فينا شيئا ليس بجسم ولا بجزء من جسمب ولا عرض ولا محتاج في وجوده إلى قوة جسيمة بل هو جوهر بسيط غير محسوس بشيء من الحواس ثم نبين ما مقصودنا منه الذي خلقنا له وندبنا إليه فنقول:
تعريف النفس
إنّا
لما وجدنا في الإنسان شياما يضاد أفعال الأجسام وأجزاء الأجسام بحده
وخواصه وله أيضا أفعال تضاد أفعال الجسمب وخواصه حتى لا يشاركه في حال من
الأحوال وكذلك نجده يباين الأعراض ويضادها كلها غاية المباينة ثم وجدنا
هذه المباينة المضادة منه للأجسام والأعراض إنما هي من حيث كانت الأجسام
أجساما والأعراض أعراضا حكمنا بأن هذا الشيء ليس بجسم ولا جزء من جسم ولا
عرضا وذلك إنه لا يستحيل ولا يتغير وأيضا فإنه يدرك جميع الأشياء بالسوية
ولا يلحقه فتور ولا كلال ولانقص {وبيان ذلك} إن كل جسم له صورة ما فإنه
ليس يقبل صورة أخرى من جنس صورته الأولى إلا بعد مفارقته الصورة الأولى
مفارقة تامة {مثال ذلك} إن الجسم إذا قبل صورة وشكلا من الأشكال كالتثليث
مثلا فليس يقبل شكلا آخر من التربيع والتدوير وغيرهما إلا بعد أن يفارقه
الشكل الأول وكذلك إذا قبل صورة نقش أو كتابة أو أي شيء كان من الصور فليس
يقبل صورة أخرى من ذلك الجنس إلا بعد زوال الأولى وبطلانها ألبته فإن بقي
فيه شيء من رسم الصورة الأولى لم يقبل الصورة الثانية على التمام بل تختلط
به الصورتان فلا يخلص له إحداهما على التمام {مثال ذلك} إذا قبل الشمع
صورة نقش في الخاتم لم يقبل غيره من النقوش إلا بعد أن يزول عنه رسم النقش
الأول وكذلك الفضة إذا قبلت صورة الخاتم وهذا حكم مستقيم مستمر في
الأجسام. ونحن نجد أنفسنا تقبل صور الأشياء كلها على اختلافها من
المحسوسات والمعقولات على التمام والكمال من غير مفارقة للأولى ولا معاقبة
ولا زوال رسم بل يبقى الرسم الأول تاما كاملا وتقبل الرسم الثاني أيضا
تاما كاملا ثم لا تزال تقبل صورة بعد صورة أبدا دائما من غير أن تضعف أو
تقصر في وقت من الأوقات عن قبول ما يرد ويطرأ عليها من الصور بل تزداد
بالصورة الأولى قوة على ما يرد عليها من الصورة الأخرى وهذه الخاصة مضادة
لخواص الأجسام ولهذه العلة يزداد الإنسان فهما كلما ارتاض وتخرج في العلوم
والآداب فليست النفس إذا جسما فأما إنها ليست بعرض فقد تبين من قبل
أنالعرض لا يحمل عرضا لأن العرض في نفسهمحمول أبا موجود في غيره لا قوام
له بذاته وهذا الجوهر الذي وصفنا حاله هو قابل أبدا حامل أتم وأكمل من حمل
الأجسام للأعراض. فإذا النفس ليست جسما ولا جزأ من جسم ولا عرضا وأيضا فإن
الطول والعرض والعمق الذي به صار الجسم جسما يحصل في النفس في قوتها
الوهمية من غير أن تصير به طويلة عريضة عميقة ثم تزداد فيها هذه المعاني
أبدا بلا نهاية فلا تصير بها أطول ولا أعرض ولا أعمق بل لا تصير بها جسما
ألبتة ولا إذا تصورة أيضا كيفيات الجسم تكيفت بها. أعني إذا تصورت الألوان
والطعوم والروائح لم تتصور بها كما تتصور الأجسام ولا يمنع بعضها قبول بعض
من أضدادها كما يمنع في الجسم بل تقبلها كلها في حالة واحدة بالسواء.
وكذلك حالها في المعقولات فإنها تزداد بكل معقول تحصله قوة على قبول غيره
دائما أبدا بلا نهاية وهذه حالة مقابلة لا حوال الأجسام وخاصة في غاية
البعد من خواصها، وأيضا فإن الجسم قواه لا تعرف العلوم إلا من الحواس ولا
يميل غلا إليها فهي تتشوقها بالملابسة والمشابكة كالشهوات البدنية ومحبة
الإنتقام والغلبة وبالجملة كل ما يحس ويوصل إليه بالحس والجسم يزداد بهذه
الأشياء قوة ويستفيد منها تماما وكمالا لأنها مادته وأسباب وجوده فهو يفرح
بها ويشتاق إليها من أجل إنها تتمم وجوده وتزيد فيه وتمده. فأما هذا
المعنى الآخر الذي سميناه نفسا فإنه كلما تباعد من هذه المعاني البدنية
التي أحصيناها وتداخل إلى ذاته وتحلى من الحواس بأكثر ما يمكن ازداد قوة
وتماما وكمالا وتظهر له الآراء الصحيحة والمعقولات البسيطة.
وهذا إذن
أدل دليل على أن طباعه وجوهره من غير طباع الجسم والبدن وأنه أكرم جوهر أو
أفضل طباعا من كل ما في هذا العالم من الأمور الجسمانية وايضا فإن تشوقها
إلى ما ليس من طباع البدن وحرصها على معرفة حقائق الأمور الآلهية وميلها
إلى الأمور التي هي أفضل من الأمور الجسمية وإيثارها لها وإنصرافها عن
الأمور واللذات الجسمانية يدلنا دلالة واضحة إنها من جوهر أعلى وأكرم جدا
من الأمور الجسمانية.
لأنه لا يمكن في شيء من الأشياء أن يتشوق ما
ليس من طباعه وطبيعته ولا أن ينصرف عما يكمل ذاته ويقوم جوهره فإذا كانت
أفعال النفس إذا إنصرفت إلى ذاتها فتركت الحواس مخالفة لأفعال البدن
ومضادة لها في محاولاتها وإراداتها فلا محالة إن جوهرها مفارق لجوهر البدن
ومخالف له في طبعه.
وأيضا فإن النفس وإن كانت تأخذ كثيرا من مبادىء
العلوم عن الحواس فلها من نفسها مباد أخر وأفعال لا تأخذها عن الحوس ألبتة
وهي المبادىء الشريفة العالية التي تنبني عليها القياسات الصحيحة. وذلك
إنها إذا حكمت إنه ليس بين طرفي النقيض واسطة فإنها لم تأخذ هذا الحكم من
شيء آخر لم يكن أوليا. وأيضا فإن الحواس تدرك المحسوسات فقط وأما النفس
فإنها تدرك أسباب الإتفاقات وأسباب الإختلافات التي من المحسوسات وهي
معقولاتها التي لا تستعين عليها بشيء من الجسم ولا آثار الجسم. وكذلك إذا
حكمت على الحس إنه صدق أو كذب فليست تأخذ هذا الحكم من الحس لأنه لا يضاد
نفسه فيما يحكم فيه ونحن نجد النفس العاقلة فينا تستدرك شيئا كثيرا من خطأ
الحواس في مبادىء أفعالها وترد عليها أحكامها. من ذلك أن البصر يخطىء فيما
يراه من قرب ومن بعد أما خطأه في البعيد فبادراكه الشمس صغيرة مقدارها عرض
قدم وهي مثل الأرض مائة ونيفا وستين مرة يشهد بذلك البرهان العقلي فتقبل
منه وترد على الحس ما شهد به فلا يقبله. وأما خطأه في القريب فبمنزلة ضوء
الشمس إذا وقع علينا من ثقب مربعات صغار كحلل الأهواز وأشباهها التي يستظل
بها فإنه يدرك بها الضوء الواصل إلينا منها مستدير افترد النفس العاقلة
عليه هذا الحكم وتغلطه في إدراكه وتعلم إنه ليس كما يراه وتخطأ البصر أيضا
في حركة القمر والسحاب والسفينة والشاطىء ويخطأ في الأساطين المسطرة
والنخيل وأشباهها حتى يراها مختلفة في أوضاعها. ويخطىء أيضا في الأشياء
التي تتحرك على الإستدارة حتى يراها كالحلقة والطوق ويخطىء أيضا في
الأشياء الغائصة في الماء حتى يرى أن بعضه أكبر من مقداره ويرى بعضها
مكسورا وهو صحيح وبعضها معوجا وهو مستقيم وبعضها منكسرا وهومنتصب. فيستخرج
العقل أسباب هذه كلها من مباد عقلية ويحكم عليها احكاما صحيحة وكذلك الحال
في حاسة السمع وحاسة الذوق وحاسة الشم وحاسة اللمس. أعني حاسة الذوق تغلط
في الحلو تجده مرا عند الصد أو أشبهه وحاسة الشم تغلط كثيرا في الأشياء
المنتنة لا سيما في المنتفل من رائحة إلى رائحة فالعقل يرد هذه القضايا
ويقف فيها ثم يستخرج أسبابها ويحكم فيها أحكاما صحيحة والحاكم في الشيء
المزيف له أو المصحح أفضل وأعلى رتبة من المحكوم عليه وبالجملة فإن النفس
إذ علمت أن الحس صدق أو كذب فليست تأخذ هذا العلم من الحس ثم إذا علمت
أنها قد أدركت معقولاتها فليست تعلم هذا العلم من علم آخر لأنها لو علمت
هذا العلم من علم آخر لاحتاجت في ذلك العلم أيضا إلى علم آخر وهذا يمر بلا
نهاية فإذا علمها بأنها علمت ليست بمأخوذ من علم آخر البتة بل هو من ذاتها
وجوهرها أعني العقل وليست تحتاج في إدراكها ذاتها إلى شيء آخر غير ذاتها
ولهذا ما قيل في أواخر هذا العلم. إن العقل والعاقل والمعقول شيء واحد
لاغيرية شيء يتبين في موضعه. فأما الحواس فلا تحس ذواتها ولا ما هو موافق
لها كل الموافقة كما سيتبين أيضا وإذ قد تبين من هذه الأشياء بيانا واضحا
إن النفس ليست بجسم ولا بجزء من جسم ولا حال من أحوال الجسم وإنها شيء آخر
مفارق للجسم بجوهره وأحكامه وخواصه وأفعاله فتقول:
شوق النفس إلى أفعالها الخاصة بها
أما
شوقها إلى أفعالها الخاصة بها أعني العلوم والمعارف مع هربها من أفعال
الجسم الخاصة به فهو فضيلتها وبحسب طلب الإنسان لهذه الفضيلة وحرصه عليها
يكون فضله وهذا الفضل يتزايد بحسب عناية الإنسان بنفسه وانصرافه عن الأمور
العائقة له عن هذا المعنى بجهده وطاقته وقد وضح مما تقدم ما الأشياء
العائقة لنا عن الفضائل أعني الأشياء البدنية والحواس وما يتصل بها. فأما
الفضائل أنفسها فليست تحصل لنا إلا بعد أن تطهر نفوسنا من الرذائل التي هي
أضدادها أعني شهواتها الرديئة الجسمانية ونزواتها الفاحشة البهيمية. فإن
الإنسان إذا علم أن هذه الأشياء ليست فضائل بل هي رذائل تجنبها وكره أن
يوصف بها وإذا ظن أنها فضائل لزمها وصارت له عادة وبحسب التباسه وتدنسه
بها يكون بعده من قبول الفضائل. وقد يظهر للإنسان أن هذه الأشياء التي
يشتاقها البدن بالحواس ويميل إليها الجمهور أعني المآكل والمشارب والمناكح
هي رذائل وليست فضائل وأنه إذا عقلها في الحيوانات الآخر وجد كثيرا منها
أقدر على الإستكثار منها وأحرص عليها كالخنزير والكلب وأصناف كثيرة من
حيوان الماء وسباع الوحش والطير فإنها أقوى وأحرص من الإنسان علىهذه
الأشياء وأكثر احتمالا لها وليست تكون بها أفضل من الإنسان. وأيضا فإن
الإنسان إذا اكتفى من طعامه وشرابه وسائر لذاته البدنية إذا عرض عليه
الإستزادة منها كما يستزاد من الفضائل أبى ذلك وعافه وتبين له قبح صورة من
يتعاطاها لا سيما مع الإستغناء عنها والإكتفاء منها بل يتجاوز ذلك إلى
مقته وذمه بل إلى تقويمه وتأديبه. فينبغي الآن أن نقدم أمام ما نطلبه من
سعادة النفس وفضائلها كلاما يسهل به فهم ما نريده فنقول: كل موجود من
حيوان ونبات وجماد وكذلك بسائطها أعني النار والهواء والأرض والماء وكذلك
الأجرام العلوية له قوى وملكات وأفعال بها يصير ذلك الموجود هو ما هو وبها
يميز عن كل ما سواه وله أيضا قوى وملكات وأفعال بها يشارك ما سواه.
ولما
كان الإنسان من بين الموجودات كلها هو الذي يلتمس له الخلق المحمود
والأفعال المرضية وجب أن لا ننظر في هذا الوقت في قواه وملكاته التي بها
يشارك سائر الموجودات إذ كان ذلك من حق صناعة أخرى وعلم آخر يسمى العلم
الطبيعي. وأما أفعاله وقواه وملكاته التي يختص بها من حيث هو إنسان وبها
تتم إنسانيته وفضائله فهي الأمور الإرادية التي بها تتعلق قوة الفكر
والتمييز. والنظر فيها يسمى الفلسفة العلمية. والأشياء الإرادية التي تنسب
إلى الإنسان تنقسم إلى الخيرات والشرور.
وذلك أن الغرض المقصود من وجود
الإنسان إذا توجه الواحد منا إليه حتى يحصل هو الذي يجب أن يسمى به خيرا
أو سعيدا. فأما من عاقه عنها عوائق أخر فهو الشرير الشقي فإذا الخيرات هي
الأمور التي تحصل للإنسان بإرادته وسعيه في الأمور التي لها أوجد الإنسان
ومن أجلها خلق. والشرور هي الأمور التي تعوقه عن هذه الخيرات بإرادته
وسعيه أو كسله وانصرافه والخيرات قد قسمها الأولون إلى أقسام كثيرة. وذلك
إن منها ما هي شريفة ومنها ما هي ممدوحة ومنها ما هي بالقوة كذلك ونعني
بالقوة التهيؤ والإستعداد ونحن نعددها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقد
قدمنا القول أن كل واحد من الموجودات له كمال خاص وفعل لا يشاركه فيه غيره
من حيث هو ذلك الشيء أعني أنه لا يجوز أن يكون موجودا آخر سواه يصلح لذلك
الفعل منه وهذا حكم مستمر في الأمور العلوية والسفلية كالشمس وسائر
الكواكب وكأنواع الحيوان كلها كالفرس والبازي وكأنواع النبات والمعادن
وكالعناصر البسائط التي متى تصفحت أحوالها تبين لك من جميعها صحة ما قلناه
وحكمنا به. فإذا الإنسان من بين سائر الموجودات له فعل خاص به لا يشاركه
فيه غيره وهو ما صدر عن قوته المميزة المروية فكل من كان تمييزه أصح
ورويته أصدق واختياره أفضل كان أكمل في إنسانيته. وكما أن السيف والمنشار
وأن صدر عن كل واحد منهما فعله الخاص بصورته الذي من أجله عمل. فأفضل
السيوف ما كان أمضى وأنضر وما كفاه يسير من الإيماء في بلوغ كماله الذي
أعد له.
وكذلك الحال في الفرس والبازي وسائر الحيوانات فإن أفضل
الأفراس ما كان أسرع حركة وأشد تيقظا لما يريده الفارس منه في طاعة اللجام
وحسن القبول في الحركات وخفة العدو والنشاط. فكذلك الناس أفضلهم من كان
أقدر على أفعاله الخاصة به وأشد تمسكا بشرائط جوهره الذي تميز به عن
الموجودات، فإذا الواجب الذي لا مرية فيه أن نحرص على الخيرات التي هي
كمالنا والتي من أجلها خلقنا ونجتهد في الوصول إلى الإنتهاء إليها ونتجنب
الشرور التي تعوقنا عنها وتنقص حظنا منها فإن الفرص إذا قصر عن كماله ولم
تظهر أفعاله الخاصة به على أفضل أحوالها حط عن مرتبة الفرسية واستعمل
بالأكاف كما تستعمل الحمير وكذلك حال السيف وسائر الآلآات متى قصرت ونقصت
أفعالها الخاصة بها حطت عن مراتبها واستعملت استعمال ما دونها والإنسان
إذا نقصت أفعاله وقصرت عما خلق له أعني أن تكون أفعاله التي تصدر عنه وعن
رويته غير كاملة أحرى بأن يحط عن مرتبة الإنسانية إلى مرتبة البهيمية.
هذا
إن صدرت أفعاله الإنسانية عنه ناقصة غير تامة فإذا صدرت عنه الأفعال بضد
ما أعد له أعني الشرور التي تكون بالروية الناقصة والعدول بها عن جهتها
لأجل الشهوة التي يشارك فيها البهيمة أولا أو الإغترار بالأمور الحسية
التي تشغله عما عرض له من تزكية نفسه التي ينتهب بها إلى الملك الرفيع
والسرور الحقيقي وتوصله إلى قرة العين التي قال الله: (فَلاَ تَعلَمُ
نَفسٌ ما أُخفيَ لَهُم مِن قٌرَةِ أَعيُن) وتبلغه إلى رب العالمين في
النعيم المقيم واللذات التي لم ترها عين ولا سمعتها أذن ولا خطرت على قلب
بشر وانخدع عن هذه الموهبة السرمدية الشريفة بتلك الخساسات التي لا ثبات
لها. فهو حقيق بالمقت من خالقه عز وجل خليق بتعجيل العقوبة له وإراحة
العباد والبلاد منه. وإذ تبين ان سعادة كل موجود إنما هي صدور أفعاله التي
تخص صورته عنه تامة كاملة وإن سعادة الإنسان تكون في صدور أفعاله
الإنسانية عنه بحسب تمييزه ورويته وأن لهذه السعادة مراتب كثيرة بحسب
الروية والمروي فيه ولذلك قيل أفضل الروية ما كان في أفضل مروي ثم ينزل
رتبة فرتبة إلى أن ينتهي إلى النظر في الأمور الممكنة من العالم الحسي
فيكون الناظر في هذه الأشياء قد استعمل رويته والصورة الخاصة به التي صار
من أجلها سعيدا معرضا للملك الأبدي والنعيم السرمدي في أشياء دنيئة لا
وجود لها بالحقيقة فقد تبين أيضا أجناس من السعادات بالجملة وأضدادها من
الشقاوات وأجناسها وأن الخيرات والشرور في الأفعال الإرادية هي إما
باختيار الأفضل والعمل به وإما باختيار الأدون والميل إليه.
ولما كانت
هذه الخيرات الإنسانية وملكاتها التي في النفس كثيرة ولم يكن في طاقة
الإنسان الواحد القيام بجميعها وجب أن يقوم بجميعها جماعة كثيرة منهم
ولذلك وجب أن تكون أشخاص الناس كثيرة وأن يجتمعوا في زمان واحد على تحصيل
هذه السعادات المشتركة لتكميل كل واحد منهم بمعاونة الباقين له فتكون
الخيرات مشتركة والسعادة مفروضة بينهم فيتوزعونها حتى يقوم كل واحد منهم
بجزء منها ويتم للجميع بمعاونة الجميع الكمال الإنسي وتحصل لهم السعادات
الثلاث التي شرحناها في كتاب الترتيب. ولأجل ذلك وجب على الناس أن يحب
بعضهم بعضا لأن كل واحد يرى كماله عند الآخر ولولا ذلك لما تمت للفرد
سعادته فيكون إذا كل واحد بمنزلة عضو من أعضاء البدن وقوام الإنسان بتمام
أعضاء بدنه.
وقد تبين للناظر في أمر هذه النفس وقواها أنها تنقسم إلى
ثلاثة أعني القوة التي بها يكون الفكر والتمييز والنظر في حقائق الأمور
والقوة التي بها يكون الغضب والنجدة والإقدام على الأهوال والشوق إلى
التسلط والترفع وضروب الكرامات والقوة التي بها تكون الشهوة وطلب الغذاء
والشوق إلى الملاذ التي في المآكل والمشارب والمناكح وضروب اللذات الخسية
وهذه الثلاث متباينة ويعلم من ذلك ان بعضها إذا قوي أضر بالآخر وربما أبطل
أحدهما فعل الآخر وربما جعلت نفوسنا وربما جعلت قوى لنفس واحدة والنظر في
ذلك ليس يليق بهذا الموضع وأنت تكتفي في تعلم الأخلاق بأنها قوى ثلاث
متباينة تقوي إحداهما وتضعف بحسب المزاج أو العادة أوالتأدب.
فالقوة
الناطقة هي التي تسمى الملكية وآلتها التي تستعملها من البدن، الدماغ،
والقوة الشهويد التي تسمى بالبهيمية وآلتها التي تستعملها من البدن، الكبد.
والقوة
الغضبية هي التي تسمى السبعية وآلتها التي تستعملها من البدن القلب فلذلك
وجب أن يكون عدد الفضائل بحسب إعداد هذه القوى وكذلك أضدادها التي هي
رذائل فمتى كانت حركة النفس الناطقة معتدلة وغير خارجة عن ذاتها وكان
شوقها إلى المعارف الصحيحة {لا المظنونة معارف وهي بالحقيقة جهالات} حدثت
عنها فضيلة العلم وتتبعها الحكمة ومتى كانت حركة النفس البهيمية معتدلة
منقادة للنفس العاقلة غير متأبية عليها فيما نقسطه لها ولا منهمكة في
اتباع هواها حدثت عنها فضيلة العفة وتتبعها فضيلة السخاء.
ومتى كانت
حركة النفس الغضبية معتدلة تطيع النفس العاقلة فيما تقسطه لها فلا تهيج في
غير حينها ولا تحمي أكثر مما ينبغي لها حدثت منها فضيلة الحلم وتتبعها
فضيلة الشجاعة ثم يحدث عن هذه الفضائل الثلاث باعتدالها ونسبة بعضها إلى
بعض فضيلة هي كمالها وتمامها وهي فضيلة العدالة. فلذلك أجمع الحكماء علىأن
أجناس الفضائل أربع وهي الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة ولهذا لا يفتخر
أحد ولا يتباهى إلا بهذه الفضائل فقط. فأما من افتخر بآبائه وأسلافه
فلأنهم كانوا على بعض هذه الفضائل أو عليها كلها وكل واحدة من هذه الفضائل
إذا تعدت صاحبها إلى غيره تسمى صاحبها بها ومدح عليها وإذا اقتصرت على
نفسه لم يسم بها بل غيرت هذه الأسماء. أما الجود فإنه إذا لم يتعد صاحبه
سمى صاحبه منفاقا. وأما الشجاعة فإن صاحبها يسمى آنفا. وأما العلم فإن
صاحبه يسمى مستبصرا ثم إن صاحب الجود والشجاعة إذا عم غيره بفضيلتيه
وتعدتاه رجى بإحداهماواحتشم وهيب بالأخرى. وذلك في الدنيا فقط لأنهما
فضيلتان حيوانيتان. أما العلم إذا تعدى صاحبه فإنه يرجى ويحتشم في الدنيا
والآخرة لأنه فضيلة إنسانية ملكية. وأضداد هذه الفضائل الأربع أربع أيضا
وهي الجهل والشره والجبن والجور وتحت كل واحد منهذه الأجناس أنواع كثيرة
سنذكر منها ما يمكن ذكره. فأما أشخاص الأنواع فهي بلا نهاية وهي أمراض
نفسانية تحدث منها أمراض كيرة كالخوف والحزن والغضب وأنواع العشق الشهواني
وضروب من سوء الخلق وسنذكرها ونذكر علاجاتها فيما بعد إنشاء الله تعالى.
والذي يجب علينا الآن هو تحديد هذه الأشياء أعني الأجناس الأربعة التي
تحتوي على جمل الفضائل فنقول: أما الحكمة فهي فضيلة النفس الناطقة المميزة
وهي أن تعلم الموجودات كلها من حيث هي موجودة وإن شئت فقل إن تعلم الأمور
الإلهية والأمور الإنسانية ويثمر علمها بذلك أن تعرف المعقولات أيها يجب
ان يفعل وأيها يجب أن يغفل. واما العفة فهي فضيلة الحس الشهواني وظهور هذه
الفضيلة في الإنسان يكون بأن يصرف شهواته بحسب الرأى أعني أن يوافق
التمييز الصحيح حتى لا ينقاد لها ويصير بذلك حرا غير متعبد لشيء من
شهواته، وأما الشجاعة فهي فضيلة النفس الغضبية وتظهر في الإنسان بحسب
إنقيادها للنفس الناطقة المميزة واستعمال ما يوجبه الرأى في الأمور
الهائلة أعني أن لا يخاف من الأمور المفزعة إذا كان فعلها جميلا والصبر
عليها محمودا.
فأما العدالة فهي فضيلة للنفس تحدث لها من إجتماع هذه
الفضائل الثلاث التي عددناها وذلك عند مسالمة هذه القوى بعضها للبعض
وإستسلامها للقوة المميزة حتى لا تتغالب ولا تتحرك لنحو مطلوباتها على سوم
طبائعها ويحدث للإنسان بها سمة يختار بها ابدا الإنصاف من نفسه أولا ثم
الإنصاف والإنتصاف من غيره وله. وسنتكلم على كل واحدة من هذه الفضائل
بكلام أوسع من هذا إذا ذكرنا الفضائل التي تحت كل جنس من هذه الأربع إذ
كان غرضنا في هذا الموضع الإشارة إليها بالرسوم الوجيزة ليتصورها المتعلم.
والذي ينبغي الآن أن نتبع ما قدمنا بذكر أنواع هذه الأجناس وماتحت كل واحد
منها فنقول {الأقسام التي تحت الحكمةْ الذكاء. الذكر. التعقل. سرعة الفهم
وقوته صفاء الذهن سهولة التعلم وبهذه الأشياء يكون حسن الإستعداد للحكمة
فأما الوقوف على جواهر هذه الأقسام فيكون من حدودها. وذلك أن العلم
بالحدود يفهم جواهر الأشياء المطلوبة الموجودة دائما على حال واحد وهو
العلم البرهاني الذي لا يتغير ولا يدخله الشك بوجه من الوجوه.
والفضائل
التي هي بذاتها فضائل لا تكون في حال من الأحوال غير فضائل، فكذلك العلوم
بها. أما الذكاء فهو سرعة انقداح النتائج وسهولتها على النفس. اما الذكر
فهو ثبات صورة ما يخلصه العقل أو الوهم من الأمور. وأما التعقل فهو موافقة
بحث النفس عن الأشياء الموضوعة بقدر ما هي عليه. وأما صفاء الذهن فهو
استعداد لما قد لزم من المقدم. وأما سهولة التعلم فهي قوة للنفس وحدة في
الفهم بها تدرك الأمور النظرية.
الفضائل التي تحت العفة
الحياء. الدعة. الصبر. السخاء. الحرية. القاعة. الدماثة. الإنتظام. حسن الهدى. المسالمة. الوقار. الورع، أما الحياء فهو إنحصار النفس خوف إتيان القبائح والحذر من الذم والسب الصادق. وأما الدعة فهي سكون النفس عند حركة الشهوات. وأما الصبر فهو مقاومة النفس الهوى لئلا تنقاد لقبائح اللذات وأما السخاء فهو التوسط في الإعطاء وهو أن ينفق الأمور فيما ينبغي بعلىمقدار ما ينبغي وعلى ما ينبغي وتحت السخاء خاصة أنواع كثيرة نحصيها فيما بعد لكثرة الحاجة إليها.وأما الحرية فهي فضيلة للنفس بها يكتسب المال من وجهه ويعطي في وجهه وتمنع من اكتسابه منغير وجهه. وأما القناعة فهي التساهل في المآكل والمشارب والزينة. وأما الدماثة فهي حسن إنقياد النفس لما يجمل وتسرعها إلى الجميل. وأما الإنتظام فهو حال للنفس تقودها إلى حسن تقدير الأمور وترتيبها كما ينبغي. وأما حسن الهدى فهو محبة تكميل النفس بالزينة الحسنة. وأما المسألة فهي موادعة تحصل للنفس عن ملكة لا اضطرار فيها. واما الوقار فهو سكون النفس وثابتها عند الحركات التي تكون في المطالب وأما الورع فهو لزوم الأعمال الجميلة التي فيها كمال النفس.
الفضائل التي تحت الشجاعةكبر النفس. النجدة. عظم الهمة، الثبات. الصبر، الحلم. عدم الطيش، الشهامة، احتمال الكد والفرق بين الصبر والصبر الذي في العفة أنهذا يكون في الأمور الهائلة وذلك يكون في الشهوات الهائجة. اما كبر النفس فهو الإستهانة باليسير والإقتدار على حمل الكرائه فصاحبه أبدا يؤهل نفسه للأمور العظام مع استخفافه لها. وأما النجدة فهي ثقة النفس عند المخاوف حتى لا يخامرها جزع. وأما عظم الهمة فهي فضيلة للنفس تحتمل بها سعادة الجد وضدها حتى الشدائد التي تكون عند الموت. وأما الثبات فهو فضيلة للنفس تقوى بها على إحتمال الآلام ومقاومتها في الأهوال خاصة. وأما الحلم فهو فضيلة للنفس تكسبها الطمأنينة فلا تكون شغبة ولا يحركها الغضب بسهولة وسرعة.
وأما السكون الذي نعني به عدم الطيش فهو إما عند الخصومات وإما في الحروب التي يذب بها عن الحريم أو عن الشريعة. وهو قوة للنفس تقسر حركتها في هذه الأحوال لشدتها. وأما الشهامة فهي الحرص على الأعمال العظام توقعا للأحدوثة الجميلة. وأما احتمال الكد فهو قوة للنفس بها تستعمل آلات البدن في الأمور الحسية بالتمرين وحسن العادةز
؟؟
الفضائل التي تحت السخاء
الكرم. الإيثار، النيل، المواساة. السماحة المسامحة. أما الكرم فهو إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس في الأمور الجليلة القدر الكثيرة النفع كما ينبغي وباقي شرائط السخاء التي ذكرناها. وأما الإيثار فهو فضيلة للنفس بها يكف الإنسان عن بعض حاجاته التي تخصه حتى يبذله لمن يستحقه. وأما النيل فهو سرور النفس بالأفعال العظام وإبتهاجها بلزوم هذه السيرة. وأما المواساة فهي معاونة الأصدقاء والمستحقين ومشاركتهم في الأموال والأقوات. وأما السماحة فهي بذل بعض ما لا يجبز وأما المسامحة فهي ترك بعض ما يجب والجميع يكون بالإرادة والإختيار.؟
الفضائل التي تحت العدالة
الصدقة،
الألفة. صلة الرحم. المكافأة. حسن الشركة. حسن القضاء، التودد. العبادة.
ترك الحقد. مكافأة الشر بالخير. استعمال اللطف. ركوب المروءة في جميع
الأحوال. ترك المعادات. ترك الحكاية عمن ليس بعدل مرضي. البحث عن سيرة من
يحكي عنه العدل. ترك لفظة واحدة لا خير فيها مسلم فضلا عن حكاية توجب حدا
او قذفا أو قتلا أو قطعا.ترك السكون إلى قول سفلة الناس وسقطهم. ترك قول
من يكدي بين الناس ظاهرا باطنا أو يلحف في مسألة أو يلح بالسؤال فإن هؤلاء
يرضيهم الشيء اليسير فيقولون لأجله حسنا ويسخطهم إذا منعوا اليسير فيقولون
لأجله قبيحا. ترك الشره في كسب الحلال وترك ركوب الدناءة في الكسب لأجل
العيال. الرجوع إلى الله وإلى عهده وميثاقه عند كل قول يتلفظ به أو لحظ
يلحظه أو خطرة في أعدائه وأصدقائه. ترك اليمين بالله وبشيء من أسماءه
وصفاته رأسا. وليس بعدل من لم يكرم زوجته وأهلها المتصلين بها وأهل
المعرفة الباطنة به وأهل المعرفة الباطنة به. وخير الناس خيرهم لأهله
وعشيرته والمتصلين به من أخ أو ولد أو متصل بأخ أو والد أو قريب أو نسيب
أو شريك أو جار أو صديق أو حبيب. ومن احب المال حبا مفرطا لم يؤهل لهذه
المرتبة. فإن حرصه على جمع المال يصده عن استعمال الرأفة وامتطاء الحق
وبذل ما يجب ويضطره إلى الخيانة والكذب والإختلاق والزور ومنع الواجب
والإستقصاء وإستجلاب الدانق والحبة والذرة لبيع الدين والمروءة. وربما
أنفق أموالا جمة محبة منه للمحمدة وحسن الثناء ولا يريد بذلك وجه الله وما
عنده. بل يتخذها مصيدة ويجعل ذلك مكسبة ولا يعلم أن ذلك عليه سيئة ومسبة.
أماالصداقة فهي محبة صادقة يهتم معها بجميع أسباب الصديق وغيثار فعل
الخيرات التي يمكن فعلها به. وأما الألفة فهي إتفاق الآراء والإعتقادات.
وتحدث عن التواصل فيعتقد معها التضافر على تدبير العيش.
وأما صلة الرحم فهي مشاركة ذوي اللحمة في الخيرات التي تكون في الدنيا.
وأما
المكافأة فهي مقابلة الإحسان بمثله أو بزيادة عليه. وأما حسن الشركة فهو
الأخذ والإعطاء في المعاملات على الإعتدال الموافق للجميع. وأما حسن
القضاء فهو مجازاة بعدل بغير ندم ولا من. وأما التودد فهو طلب مودات
الأكفاء وأهل الفضل بحسن اللقاء وبالأعمال التي تستدعي المحبة منهم. وأما
العبادة فهي تعظيم الله تعالى وتمجيده وطاعته وإكرام أوليائه من الملائكة
والأنبياء والأئمة والعمل بما توجبه الشريعة وتقوى الله تعالى تتم هذه
الأشياء وتكملها، وإذ قد تقصينا الفضائل الأولى وأقسامها وذكرنا أنواعها
وأجزاءها فقد عرفنا الرذائل التي تضاد الفضائل لأنه يفهم من كل واحدة من
تلك الفضائل كلها ما يقابلها لأن العلم بالأضداد واحد.
ولما كانت هذه
الفضائل أوساطا بين أطراف وتلك الأطراف هي الرذائل وجب أن تفهم منها وأن
اتسع لنا الزمان ذكرناها لأن وجود أسمائها في هذا الوقت متعذر وينبغي ان
تفهم من قولنا أن كل فضيلة فهي وسد بين رذائل ما أنا واصفه.
إن
الأرض لما كانت في غاية البعد من السماء قيل إنها وسط وبالجملة المركز من
الدائرة هو على غاية البعد من المحيط وإذا كان الشيء على غاية البعد من
شيء آخر فهو من هذه الجهة على القطر. فعلى هذا الوجه يبنغي أن يفهم معنى
الوسط من الفضيلة إذا كانت بين رذائل بعدها منها أقصى البعد ولهذا إذا
انحرنفت الفضيلة عن موضعها الخاص بها أدنى انحراف قربت من رذيلة أخرى ولم
تسلم من العيب بحسب قربها من تلك الرذيلة التي تميل إليها ولهذا صعب جدا
وجود هذا الوسط ثم التمسك به بعد وجوده أصعب لذلك قالت الحكماء إصابة نقطة
الهدف أعسر من العدول عنها ولزوم الصواب بعد ذلك حتى لا يخطأها أعسر
وأصعب. وذلك أن الأطراف التي تسمى رذائل من الأفعال والأحوال والزمان
وسائر الجهات كثيرة جدا. ولذلك كانت دواعي الشر أكثر من دواعي الخير ويجب
أن تطلب أوساط تلك الأطراف بحسب كل فرد فرد. فأما ما يجب على المؤلف فهو
أن يذكر جمل هذه الأوساط وقوانينها بحسب ما يليق بالصناعة لا على ما يجب
على كل شخص فإن هذا غير ممكن فإن النجار والصائغ وجميع أرباب الصناعات
إنما يحصل في نفوسهم قوانين وأصول فيعرف النجار صورة الباب والسرير
والصائغ صورةالخاتم والتاج على الإطلاق. فأما أشخاص ماقام في نفسه فإنما
يستخرجها بتلك القوانين ولا يمكنه تعرف الأشخاص لأنها بلا نهاية. وذلك أن
كل باب وخاتم إنما يعمل بمقدار ما ينبغي وعلى قدر الحاجة وبحسب المادة.
والصناعة
لا تضمن إلا معرفة الأصول فقط. وإذ قد ذكرنا معنى الوسط في الأخلاق
وماينبغي أن يفهم منه فلنذكر هذه الأوساط لتفهم منها الأطراف التي هي
رذائل وشرور فنقول وبالله التوفيق.
أما الحكمة فهي وسط بين السفه
والبله وأعني بالسفه ههنا إستعمال القوة الفكرية فيما لا ينبغي وكمالا
ينبغي. وسماه القوم الجزيرة وأعني بالبله تعطيل هذهالقوة وإطراحها وليس
بنبغي أن يفهم أن البله ههنا نقصان الخلقة بل ما ذكرته من تعطيل القوة
الفكرية بالإرادة. وأما الذكاء فهو وسط بين الخبث والبلادة فإن أحد طرفي
كل وسط إفراط والآخر تفريط أعني الزيادة عليه والنقصان منه فالخبث والدهاء
والحيل الرديئة هي كلها إلى جانب الزيادة فيما ينبغي أن يكون الذكاء فيه.
وأما البلادة والبله والعجز عنغدراك المعارف فهي كلها إلى جانب النقصان من
الذكاء. وأما الذكر فهو وسط بين النسيان الذي يكون بإهمال ما ينبغي أن
يحفظ وبين العناية بما لا ينبغي أن يحفظ. وأما التعقل - وهو حسن التصور -
فهووسط بين الذهاب بالنظر في الشيء الموضوع إلى أكثر مما هو عليه وبين
القصور وبالنظر فيه عما هو عليه. وأما سرعة الفهم فهي وسط بين إختطاف خيال
الشيء من غير إحكام لفهمه. وبين الإبطاء عن فهم حقيقته. وأما صفاء الذهن
فهو وسط بين ظلمة النفس عن إستخراج المطلوب بوبين التهاب يعرض فيها
فيمنعها من استخراج المطلوب وأما جودة الذهن وقوته فهو وسط بين الإفراط في
التأمل لما لزم من المقدم حتى يخرج منه إلى غيره وبين التفريط فيه حتى
يقصر عنه.
وأما سهولة التعلم فهي وسط بين المبادرة إليه بسلاسة تثبت معها صورة العلم وبين التعصب عليه وتعذره.
وأما
العفة فهي وسط بين رذيلتين وهما الشره وخمود الشهوة. وأعني بالشره
الإنهماك في اللذات والخروج فيها عما ينبغي وأعني بخمود الشهوة السكون عن
الحركة التي تسلك نحو اللذة الجميلة التي يحتاج إليها البدن في ضروراته
وهي ما رخص فيه صاحب الشريعة والعقل.
وأما الفضائل التي تحت العفة فإن
الحياء وسط بين رذيلتين. إحداهما لوقاحة والأخرى الخرق. وأنت تقدر على أن
تلحظ أطراف الفضائل الأخرى التي هي رذائل وربما وجدت لها أسماء بحسب اللغة
وربما وجدت لها إسما وليس يعسر عليك فهم معانيها والسلوك فيها على السبيل
التي سلكناها {وأما الشجاعة} فهي وسط بين رذيلتين إحداهما الجبن والأخرى
التهور. أما الجبن فهو الخوف مما لا ينبغي ان يخاف منه. وأما التهور فهو
الإقدام على ما لا ينبغي أن يقدم عليه وأما السخاء فهو وسط بين رذيلتين
إحداهما السرف والتبذير والأخرى البخل والتقتير. أما التبذير فهو بذل ما
لا ينبغي لمن لا يستحق.
وأما التقتير فهومنع ما ينبغي عمن يستحق
{وأما العدالة} فهي وسط بين الظلم والإنظلام، أما الظلم فهو التوصل إلى
كثرة المقتنيات من حيث لا ينبغي كما لا ينبغي. وأما الإنظلام فهو
الإستحذاء والإستماتة في المقتنيات لمن لا ينبغي وكما لا ينبغي. ولذلك
يكون للجائر أموال كثيرة لأنه يتوصل إليها من حيث لا يجب ووجوه التوصل
إليها كثيرة. وأما المنظلم فمقتنياته وأمواله يسيرة جدا لأنه يتركها من
حيث لا يجب. وأما العادل فهو في الوسط لأنه يقتني الأموال من حيث يجب.
ويتركها من حث لا يجب. فالعدالة فضيلة ينصف بها الإنسان من نفسه ومن غيره
من غير أن يعطي نفسه من النافع أكثر وغيره أقل. وأما في الضار فبالعكس وهو
أن لا يعطي نفسه أقل وغيره أكثر لكن يستعمل المساواة التي هي تناسب ما بين
الأشياء ومن هذا المعنى اشتق اسمه أعني العدل.
وأما الجائر فأنه يطلب
لنفسه الزيادة من المنافع ولغيره النقصان منها وأما في الأشياء الضارة
فإنه يطلب لنفسه النقصان ولغيره الزيادة منها. فقد ذكرنا الأخلاق التي هي
خيرات وفضائل وأطرافها التي هي شرور ورذائل على طريق الإيجاز وحددنا ما
يحد منها ورسمنا ما يرسم وسنشرح كل واحد منها على سبيل الإستقصاء فيما بعد
إن شاء الله تعالى.
وينبغي أن نلخص في هذا الموضع شكا ربما لحق طالب
هذه الفضائل فنقول: أنا قد بينا فيما تقدم أن الإنسان من بين جميع الحيوان
لا يكتفي بنفسه في تكميل ذاته. ولا بد له من معاونة قوم كثيرى العدد حتى
يتمم به حياته طيبة ويجري أمره على السداد. ولهذا قال الحكماء أن الإنسان
مدني بالطبع أي هو محتاج إلى مدينة فيها خلق كثير لتتم له السعادة
الإنسانية فكل بالطبع وبالضرورة يحتاج إلى غيره فهو لذلك مضطر إلى مصافاة
الناس ومعاشرتهم العشرة الجميلة ومحبتهم المحبة الصادقة لأنهم يكملون ذاته
ويتممون إنسانيته وهو أيا يفعل بهم مثل ذلك. فإذا كان كذلك بالطبع
وبالضرورة فكيف يؤثر الإنسان العاقل العارف بنفسه التفرد والتخلي ولا
يتعاطى ما يرى الفضيلة في غيره. فإذا القوم الذين رأوا الفضيلة في الزهد
وترك مخالطة الناس وتفردوا عنهم إما بملازمة المغارات في الجبال وأما
ببناء الصوامع في المفاوز. وأما بالسياحة في البلدان لا يحصل لهم شيء من
الفضائل الإنسانية التي عددنها. ذلك أن من لم يخالط الناس ولم يساكنهم في
المدن لا تظهر فيه العفة ولا النجدة ولا السخاء ولا العدالة بل تصير قواه
وملكاته التي ركبت فيه باطلة لأنها لا تتوجه لا إلى خير ولا إلى شر فإذا
بطلت ولم نظهر أفعالها الخاصة بها صاروا بمنزلة الجمادات والموتى من الناس
ولذلك يظنون ويظن بهم أنهم أعفاء وليسوا بإعفاء وأنهم عدول وليسوا بعدول
وكذلك في سائر الفضائل اعني أنه إذا لم يظهر منهم أضداد هذه التي هي شرور.
ظن بهم الناس أنهم أفاضل وليست الفضائل إعداما بل هي أفعال وأعمال تظهر
عند مشاركة الناس ومساكنتهم وفي المعاملات وضروب الإجتماعات. ونحن إنما
نعلم ونتعلم الفضائل الإنسانية التي نساكن بها الناس ونخالطهم ونصبر على
أذاهم لنصل منها وبها إلى سعادات أخر إذا صرنا إلى حال أخرى. وتلك الحال
غير موجودة لنا الآن.
المقالة الثانية
" الخلق "
الخلق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية ولا روية. وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيا من أصل المزاج كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب ويهيج من أقل سبب وكالإنسان الذي يجبن من أيسر شيء كالذي يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه أو يرتاع من خبر يسمعه وكالذي يضحك ضحكا مفرطا من أدنى شيء يعجبه وكالذي يغتم ويحزن من أيسر شيء يناله، ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدرب وربما كان مبدؤه بالروية والفكر ثم يستمر عليه أولا فأولا حتى يصير ملكة وخلقا.ولهذا اختلف القدماء في الخلق
فقال بعضهم الخلق خاص بالنفس غير الناطقة وقال بعضهم قد يكون للنفس
الناطقة فيه حظ. ثم اختلف الناس أيضا اختلافا ثانيا فقال بعضهم من كان له
خلق طبيعي لم ينتقل عنه وقال آخرون ليس شيء من الأخلاق طبيعيا للإنسان ولا
نقول أنه غير طبيعي. وذلك أنا مطبوعون على قبول الخلق بل ننتقل بالتأديب
والمواعظ إما سريعا أو بطيئا. وهذا الرأي الأخير هو الذي نختاره لأنا
نشاهده عيانا ولأن الرأى الأول يؤدي إلى أبطال قوة التمييز والعقل وإلى
رفض السياسات كلها وترك الناس همجا مهملين وإلى ترك الأحداث والصبيان على
ما يتفق أن يكونوا عليه بغير سياسة ولا تعليم وهذا ظاهر الشناعة جدا.
وأما
الرواقيون فظنوا أ، الناس كلهم يخلقون أخيارا بالطبع ثم بعد ذلك يصيرون
أشرارا بمجالسة أهل الشر والميل إلى الشهوات الرديئة التي لا تقمع
بالتأديب فينهمك فيها ثم يتوصل إليها من كل وجه ولا يفكر في الحسن منها
والقبيح. وقوم آخرون كانوا قبل هؤلاء ظنوا أن الناس خلقوا من الطينة
السفلى وهي كدر العالم فهم لأجل ذلك أشرار بالطبع.
وإنما يصيرون أخيارا
بالتأديب والتعليم إلا أن فيهم منهو في غاية الشر لا يصلحه التأديب وفيهم
من ليس في غاية الشر فيمكن أن ينتقل من الشر إلى الخير بالتأديب من الصبا
ثم بمجالسة الأخيار وأهل الفضل، فأما جالينوس فإنه رأى أن الناس فيهم من
هو خير بالطبع وفيهم من هو شرير بالطبع وفيهم من هو متوسط بين هذين. ثم
أفسد المذهبين الأولين اللذي ذكرناهما أما الأول فبأن قال أن كان كل الناس
أخيارا بالطبع وإنما ينتقلون إلى الشر بالتعليم فالبضرورة إما أن يكون
تعلمهم الشرور من أنفسهم وإما من غيرهم. فإن تعلموا من غيرهم فإن المعلمين
الذين علموهم الشر أشرار بالطبع. فليس الناس إذا كلهم أخيارا بالطبع. وإن
كانوا تعلموه من أنفسهم فإما أن يكون فيهم قوة يشتاقون بها إلى الشر فقط
فهم إذاً أشرار بالطبع.
وأما الرأى الثاني فإنه أفسده بمثل هذه الحجة.
وذلك أنه قال إن كان كل الناس أشرارا بالطبع فإما أن يكونوا تعلموا الخير
من غيرهم أو من أنفسهم ونعيد الكلام الأول بعينه، ولما أفسد هذين المذهبين
صحح رأى نفسه من الأمور البينة الظاهرة. وذلك أنه ظاهر جدا أن من الناس من
هو خير بالطبع وهم قليلون وليس ينتقل هؤلاء إلى الشر ومنهم من هو شرير
بالطبع وهم كثيرون وليس ينتقل هؤلاء إلى الخير. ومنهم من هو متوسط بين
هذين وهؤلاء قد ينتقلون بمصاحبة الأخيار ومواعظهم إلى الخير وقد ينتقلون
بمقاربة أهل الشر وإغوائهم إلى الشر.
وأما أرسطو طاليس فقد بين في
كتاب الأخلاق وفي كتاب المقولات أيضا أن الشرير قد ينتقل بالتأديب إلى
الخير. ولكن ليس على الإطلاق لأنه يرى أن تكرير المواعظ والتأديب وأخذ
الناس بالساياسات الجيدة الفاضلة لا بد أن يؤثر ضروب التأثير في ضروب
الناس فمنهم من يقبل التأديب ويتحرك إلى الفضيلة بسرعة ومنهم من يقبله
ويتحرك إلى الفضيلة بابطاء. ونحن نؤلف من ذلك قياسا وهو هذا: كل خلق يمكن
تغيره. ولا شيء مما يمكن تغيره هو بالطبع. فإذا لا خلق ولا واحد منه
بالطبع. والمقدمتان صحيحتان والقياس منتج في الضرب الثاني من الشكل الأول.
أما تصحيح المقدمة الأولى. وهي أن كل خلق يمكن تغيره فقد تكلمنا عليه
وأوضحناه وهو بين من العيان ومما استدللنا به من وجوب التأديب ونفعه
وتأثيره في الأحداث والصبيان ومن الشرائع الصادقة التي هي سياسة الله
لخلقه وإما تصحيح المقدمة الثانية وهي أنه لا شيء مما يمكن تغيره هو
بالطبع فهو ظاهر أيضا. وذلك أنا لا نروم تغيير شيء مما هو بالطبع أبدا.
فإن أي أحد لا يروم أن يغير حركة النار التي إلى فوق بأن يعودها الحركة
إلى أسفل ولا أن يعود الحجر حركة العلوم يروم بذلك أن يغير حركة الطبيعة
التي إلى أسفل. ولو رامه ما صح له تغيير شيء من هذا ولا ما يجري مجراه
أعني الأمور التي هي بالطبع فقد صحت المقدمتان وصح التأليف في الشكل الأول
وهو الضرب الثاني منه وصار برهانا. فأما مراتب الناس في قبول هذه الآداب
التي سميناها خلقا والمسارعة إلى تعلمها والحرص عليها فإنها كثيرة وهي
تشاهد وتعاين فيهم وخاصة في الأطفال فإن أخلاقهم تظهر فيهم منذ بدء نشأتهم
ولا يسترونها بروية ولا فكر كما يفعله الرجل التام الذي انتهى في نشؤه
وكماله إلى حيث يعرف من نفسه ما يستقبح منه فيخفيه بضروب من الحيل
والأفعال المضادة لما في طبعه: وأنت تتأمل من أخلاق الصبيان واستعدادهم
لقبول الأدب أو نفورهم عنه أو ما يظهر في بعضهم من القحة وفي بعضهم من
الحياء وكذلك ما ترى فيهم من الجود والبخل والرخمة والقسوة والحسد وضده
ومن الأحوال المتفاوتة ما تعرف به مراتب الإنسان في قبول الأخلاق الفاضلة
وتعلم معه أنهم ليسوا على رتبة واحدة وأن فيهم المتواني والممتنع والسهل
السلس والفظ العسر والخير والشرير. والمتوسطون بين هذه الأطراف في مراتب
لا تحصى كثرة وإذا أهملت الطباع ولم ترض بالتأديب والتقويم نشأ كل إنسان
على رسوم طباعه وبقي عمره كله على الحال التي كان عليها في الطفولية وتبع
ما وافقه في الطبع أما الغضب وأما اللذة وأما الزعارة وأما الشره وأما غير
ذلك من الطباع المذمومة.
الشريعة
والشريعة هي التي تقوم الأحداث وتعودهم الأفعال المرضية وتعد نفوسهم لقبول الحكمة وطلب الفضائل والبلوغ إلى السعادة الإنسية بالفكر الصحيح والقياس المستقيم وعلى الوالدين أخذهم بها وسائر الآداب الجميلة بضروب السياسات من الضروب إذا دعت إليه الحاجة أو التوبيخات أن صدتهم أو الأطماع في الكرامات أو غيرها مما يميلون إليه من الراحات أو يحذرونه من العقوبات. حتى إذا تعودوا ذلك واستمروا عليه مدة من الزمان كثيرة أمكن فيهم حينئذ أن يعلموا برهين ما أخذوه تقليدا وينبهوا على طرق الفضائل وإكتسابها والبلوغ إلى غاياتها بهذه الصناعة التي نحن بصددها.والله الموفق وللإنسان في ترتيب هذه الآداب وسياقها أولا فأولا إلى الكمال الأخير طريق طبيعي يتشبه فيها بفعل الطبيعة. وهو أن ينظر إلى هذه القوى التي تحدث فينا أيها أسبق إلينا وجودا فيبدأ بتقويمها ثم بما يليها على النظام الطبيعي وهو بين ظاهر. وذللك أن أول ما يحدث فينا هو الشيء العام للحيوان والنبات كله ثم لا يزال يختص بشيء شيء يتميز به عن نوع نوع إلى أن يصير إلى الإنسانية. فلذلك يجب أن نبدأ بالشوق الذي يحصل فينا إلى الغضب ومحبة الكرامة فنقومه ثم بآخره وهو الشوق الذي يحصل فينا إلى المعارف والعلوم فنقومه. وهذا الترتيب الذي قلنا أنه طبيعي إنما حكمنا فيه لما يظهر فينا منذ أول نشونا أعني أن نكون أولا أجنة ثم أطفالا ثم أناسا كاملين وتحدث فينا هذه القوى مرتبة. فأما أن هذه الصناعة هي أفضل الصناعات كلها أعني صناعة الأخلاق التي تعني بتجويد أفعال الإنسان بحسب ما هو إنسان فيتبين مما أقول.
الإنسان
لما كان
للجوهر الإنساني فعل خاص لا يشاركه فيه شيء من موجودات العالم كما بيناه
فيما تقدم، وكان الإنسان أشرف موجودات عالمنا ثم لم تصدر عنه أفعاله بحسب
جوهره وشبهناه بالفرس الذي إذا لم تصدر عنه أفعال الفرس على التمام استعمل
مكان الحمار بالاكاف وكان وجوده أروح له من عدمه وجب أن تكون الصناعة التي
تعني بتجويد أفعال الإنسان حتى تصدر عنه أفعاله كلها تامة كاملة بحسب
جوهره ورفعه عن رتبة الأخس التي يستحقق بها المقت من الله والقرار في
العذاب الأليم أشرف الصناعات كلها وأكرمها. وأما سائر الصناعات الأخر
فمراتبها من الشرف بحسب مراتب جوهر الشيء الذي تستصلحه وهذا ظاهر جدا من
تصفح الصناعات لأن فيها الدباغة التي تعني باستصلاح جلود البهائم الميتة
وفيها صناعة الطب والعلاج التي تهتم باستصلاح الجواهر الشريفة الكريمة
وهكذا الهمم المتفاوتة التي ينصرف بعضها إلى العلوم الدنيئة وبعضها إلى
العلوم الشريفة. وإذا كانت جواهر الموجودات متفاوتة في الشرف في الجماد
والنبات والحيوان. أما في الحيوان فكجوهر الديدان والحشرات إذا قيس إلى
جوهر الإنسان. وإما في جوهر الموجودات الآخر فظاهر لمن أراد أن يحصيها.
فالصناعة والهمة التي تصرف إلى أشرفها أشرف من الصناعة والهمة التي تصرف
إلى الأدون منها. ويجب أن يعلم ان اسم الإنسان وإن كان يقع على أفضلهم
وعلى أدونهم فإن بين هذين الطرفين أكثر مما بين كل متضادين من البعد. وإن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {ليس شيء خيرا من ألف مثله الإنسان "
وقال: عليه الصلاة والسلام " الناس كابل مائة لا تجد فيها راحلة واحدة "
وقال: " الناس كأسنان المشط وفي بعضها كأسنان الحمار وإنما يتفاضلون
بالعقل. ولا خير في صحبة من لا يعرف لك من الفضل ما تعرف له " وفي نظائر
هذه أشياء كثيرة تدل على هذا المعنى وأن الشاعر الذي قال: (ولم أر أمثال
الرجال تفاوتا إلى المجد حتى عد ألف بواحد) وإن كان عنده أنه قد بالغ فإنه
قد قصر. والخبر الخمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام " إني وزنت بأمتي
فرجحت بهم " أصدق وأوضح. وليس هذا في الإنسان وحده بل في كثير من الجواهر
الأخر. وإن كان في الإنسان أكثر وأشد تفاوتا فإن بين السيف المعروف
بالصمصام وبين السيف المعروف بالكهام تفاوتا عظيما. وكذلك الحال في
التفاوت الذي بين الفرس الكريم وبين البرذون المقرف فمن أمكنه أني رقى
بالصناعة منأدون هذه الجواهر مرتبة إلى أعلاها فاشرف به وبصناعته ما أكرمه
وأكرمها. فأما الإنسان من بين هذه الجواهر فهو مستعد بضروب من الإستعدادات
لضروب من المقامات. وليس ينبغي أن يكون الطمع في إستصلاحه على مرتبة واحدة
وهذا شيء يتبين فيما بعد بمشيئة الله وعونه. إلا أن الذي ينبغي أن يعلم
الآن أن وجود الجوهر الإنساني متعلق بقدرة فاعله وخالقه تبارك وتقدس إسمه
وتعالى. فأما تجويد جوهره فمفوض إلى الإنسان وهو معلق بإرادته. فاعرف هذه
الجملة إلى أن تلخص في موضعها إن شاء الله تعالى. وقد قدمنا في صدر هذا
الكتاب إن قلنا ينبغي أن نعرف نفوسنا ما هي ولأي شيء هي. ثم قنا إن لكل
جوهر موجود كمالا خاصا به وفعلا لا يشاركه فيه غيره من حيث هو ذلك الشيء
وقد بينا ذلك في غاية البيان في الرسالة المسعدة. وإذا كان ذلك محفوظا
فنحن مضطرون إلى أن نعرف الكمال الخاص بالإنسان والفعل الذي لا يشاركه فيه
غير منحيث هو إنسان لنحرص على طلبه وتحصيله ونجتهد في البلوغ إلى غايته
ونهايته. ولما كان الإنسان مركبا لم يجز أن يكون كماله وفعله الخاص به
كمال بسائطه وأفعالها الخاصة بها وإلا كان وجود المركب باطلا كالحال في
الخاتم والسرير. فإذا له فعل خاص به من حيث هو مركب وإنسان لا يشاركه فيه
شيء من الموجودات الأخر. فأفضل الناس أقدرهم على إظهار فعله الخاص والزمهم
له من غير تلون فيه ولا إخلال به في وقت دون وقت. وإذا عرف الأفضل فقد عرف
الأنقص على إعتبار الضد، فالكمال الخاص بالإنسان كمالان وذلك أن له قوتين
إحداهما العالمة والأخرى العاملة فلذلك يشتاق بإحدى القوتين إلىالمعارف
والعلوم وبالأخرى إلى نظم الأمور وترتيبها وهذان الكمالان هما اللذان نص
عليهما الفلاسفة فقالوا.
الفلسفة
تنقسم إلى قسمين إلى
الجزء النظري والجزء العملي فإذا كمل الإنسان بالجزء العملي والجزء النظري
فقد سعد السعادة التامة، أما كماله الأول بإحدى قوتيه أعني العالمة وهي
التي يشتاق بها إلى العلوم فهو أن يصير في العلم بحيث يصدق نظره وتصح
بصيرته وتستقيم رويته فلا يغلط في إعتقاد ولا يشك في حقيقة وينتهي في
العلم بأمور الموجودات على الترتيب إلىالعلم الإلهي الذي هو آخر مرتبة
العلوم ويثق به ويسكن إليه ويطئن قلبه وتذهب حيرته وينجلي له المطلوب
الأخير حتى يتحد به وهذا الكمال قد بينا بالقوة الأخرى أعني القوة العاملة
فهو الذي نقصده في كتابنا هذا وهو الكمال الخلقي ومبدؤه من ترتيب قواه
وأفعاله الخاصة بها حتى لا تتغالب وحتى تتسالم هذه القوى فيه وتصدر أفعاله
كلها بحسب قوته المميزة منتظمة مرتبة كما ينبغي وينتهي إلي التدبير المدني
الذي يرتب الأفعال والقوى بين الناس حتى تنتظم ذلك الإنتظام ويسعدوا سعادة
مشتركة كما كان ذلك في الشخص الواحد. فإذا الكمال الأول النظري منزلته
منزلة الصورة والكمال الثاني العملي منزلته منزلة المادة وليس يتم أحدهما
إلا بالآخر لأن العلم مبدأ والعمل تمام والمبدأ بلا تمام يكون ضائعا
والنمام بلا مبدأ يكون مستحيلا وهذا الكمال هو الذي سميناه غرضا.
وذلك
أن الغرض والكمال بالذات هما شيء واحد وإنما يختلفان بالإضافة فإذا نظر
إليه وهوبعد في النفس ولم يخرج إلي الفعل فهو غرض فإذا خرج إلي الفعل وتم
فهو كمال. وكذلك الحال في كل شيء لأن البيت إذا كان متصورا للباني وكان
عالما بأجزائه وتركيبه وسائر أحواله كان غرضا. فإذا أخرجه إلي كماله ويصدر
عنه فعله الخاص به إذا علم الموجودات كلها أي يعلم كلياتها وحدودها التي
هي ذواتها لا أعراضها وخواصها التي تصيرها بلا نهاية.
فإنك إذا علمت
كليات الموجودات فقد علمت جزئياتها بنحو مالان الجزئيات لاتخرج عن كلياتها
فإذا كملت هذا الكمال فتممه بالفعل المنظوم ورتب القوى والملكات التي فيك
ترتيبا علميا كما سبق علمك به. فإذا انتهيت إلى هذه الرتب فقد صرت عالما
وحك واستحقيت أن تسمى عالما صغيرا لأن صور الموجودات كلها قد حصلت في ذاتك
فصرت أنت هي بنحو ما. ثم نظمتها بأفعالك على نحو استطاعتك فصرت فيها خليفة
لمولاك خالق الكل جلت عظمته فلم تخط فيها ولم تخرج عن نظامه الأول الحكمى
فتصير حينئذ عالما تاما. والتام من الموجودات هو الدائم الوجد والدائم
الوجود هو الباقي بقاء سرمديا فلا يفوتك حينئذ شيء من النعيم المقيم لأنك
بهذا الكمال مستعد لقبول الفيض من المولى دائما أبدا وقد قربت منه القرب
الذي لا يجوز أن يحول بينك وبينه حجاب. وهذه هي الرتبة العليا والسعادة
القصوى. ولولا أن الشخص الواحد من أشخاص الناس يمكنه تحصيل هذه المنزلة في
ذاته وتكميل صورته بها وإتمام نقصانه بالترقي إليها لكان سبيله سبيل أشخاص
الحيوانات الأخر أو كسبيل أشخاص النبات في مصيرها إلى الفناء والإستحالة
التي تلحقها والنقصانات التي لا سبيل إلى تمامها. ولإستحال فيه البقاء
الأبدي والنعيم السرمدي والمصير إلى ربه ودخول جنته. ومن لا يتصور هذه
الحالة ولا ينتهي إلى علمها من المتوسطين في العلم يقع له شكوك. فيظن أن
الإنسان إذا انتقض تركيبه الجسماني بطل وتلاشى كالحال في الحيوانات الأخر
وفي النبات فحينئذ يستحق إسم الإلحاد ويخرج عن سمة الحكمة وسنة الشريعة.
كمال الإنسان في الذات المعنوية
وقد
ظن قوم أن كمال الإنسان وغايته هما في اللذات وإنها هي الخير المطلوب
والسعادة القصوى. وظنوا أن جميع قواه اخر " إنما ركبت فيه من أجل هذه
اللذات والتوصل إليها. وأن النفس الشريفة التي سميناها ناطقة إنما وهبت له
ليرتب بها الأفعال ويميزها ثم يوجهها نحو هذه اللذات لتكون الغاية الأخيرة
هي حصولها له على النهاية والغاية الجسمانية. وظنوا أيضا أن قوى النفس
الناطقة أعني الذكر والحفظ والروية كلها تراد لتلك الغاية. قالوا وذلك أن
الإنسان إذا تذكر اللذات التي كانت حصلت له بالمطاعم والمشارب والمناكح
اشتاق إليها وأحب معاودتها فقد صارت منفعة الذكر والحفظ إنما هي اللذات
وتحصيلها. ولأجل هذه الظنون التي وقعت لهم جعلوا النفس المميزة الشريفة
كالعبد المهين وكالأجير المستعمل في خدمة النفس الشهوية لتخدمها في المآكل
والمشارب والمناكح وترتبها لها وتعدها إعدادا كاملا موافقا. وهذا هو رأي
الجمهور من العامة الرعاع وجهال الناس السقاط.
وإلى هذه الخيرات التي
جعلوها غاياتهم تشوقوا عند ذكر الجنة والقرب من بارئهم عزوجل. وهي التي
يسألونها ربهم تبارك وتعالى في دعواتهم وصلواتهم. وإذا خلوا بالعبادات
وتركوا الدنيا وزهدوا فيها فإنما ذاك منهم على سبيل المتجر والمرابحة في
هذه بعينها. كأنهم تركوا قليلها ليصلوا إلى كثيرها وأعرضوا عن الفانيات
منها ليبلغوا إلى الباقيات. إلا انك تجدهم مع هذا الإعتقاد وهذه الأفعال
إذا ذكر عندهم الملائكة والخلق الأعلى الأشرف وما نزههم الله عنه من هذه
القاذورات علموا بالجملة أنهم أقرب إلى الله تعالى وأعلى رتبة من الناس
وأنهم غير محتاجين إلى شيء من حاجات البشرز بل يعلمون أن خالقهم وخالق كل
شيء الذي تولى إبداع الكل هو منزه عن هذه الأشياء متعال عنها غير موصوف
باللذة والتمتع مع التمكن من إيجادها. وإن الناس يشاركون في هذه اللذات
الخنافس والديدان وصغار الحشرات والهمج من الحيوان. وإنما يناسبون
الملائكة بالعقل والتمييز ثم يجمعون بين هذا الإعتقاد والإعتقاد الأول.
وهذا هوالعجب العجيب. وذلك أنهم يرون عيانا ضروراتهم بالأذى الذي يلحقهم
بالجوع والعرى وضروب النقص وحاجاتهم إلى مداواتها بما يدفعها عنهم. فإذا
زالت آثارها وعادوا إلى حال السلامة منها التذوا بذلك ووجدوا للراحة لذة.
ولا يشعرون أنهم إذا اشتاقوا إلى لذة المآكل فقد اشتاقوا أولا إلى ألم
الجوع. وذلك أنهم إن لم يؤلموا بالجوع لم يلتذوا بالأكل. وهكذا الحال في
سائر اللذات الأخر. إلا أن هذا الحال في بعضها أظهر منها في بعض. وسنتكلم
على أن صورة الجميع واحدة وأن اللذات كلها إنما تحصل للملتذ بعد آلام
تلحقه. لأن اللذة هي راحة من ألم وأن كل لذة حسية إنما هي خلاص من ألم أو
أذى في غير هذا الموضع.
وسيظهر عند ذلك أن من رضي لنفسه بتحصيل اللذات
البدنية وجعلها غايته وأقصى سعادته فقد رضى بأخس العبودية لأخص الموالي.
لأنه يصير نفسه الكريمة التي يناسب بها الملائكة عبدا للنفس الدنيئة التي
يناسب بها الخنازير والخنافس والديدان وخسائس الحيوانات التي تشاركه في
هذا الحال.
وقد تعجب جالينوس في كتابه الذي سماه بأخلاق النفس من
هذا الرأي وكثر استجهاله للقوم الذين هذه مرتبتهم من العقل. إلا أنه قال
أن هؤلاء الخبثاء الذين سيرتهم أسوأ السير وإرداؤها إذا وجدوا إنسانا هذا
رأيه ومذهبه نصروه ونوهوا به ودعوا إليه ليوهموا بذلك أنهم غير منفردين
بهذه الطريقة لأنهم يظنون أنهم متى وصف أهل الفضل والنبل من الناس بمثل ما
هم عليه كان ذلك عذرا لهم وتمويها على قوم آخرين في مثل طريقتهم. وهؤلاء
هم الذين يفسدون الأحداث بإيهامهم أن الفضيلة هي ما تدعوهم إليه طبيعة
البدن من الملاذ. وأن تلك الفضائل الأخر الملكية إما أن تكون باطلة ليست
بشيء ألبتة وإما أن تكون غير ممكنة لأحد من الناس: والناس مائلون بالطبع
الجسداني إلى الشهوات فيكثر اتباعهم وتقل الفضلاء فيهم. وإذا تنبه الواحد
بعد الواحد منهم إلى أن هذه اللذات إنما هي لضرورة الجسد وإن بدنه مركب من
الطبائع المتضادة أعني الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة وأنه إنما
يعالج بالمأكل والمشرب أمراضا تحدث به عند الإنحلال لحفظ تركيبه على حالة
واحدة أبدا ما أمكن ذلك فيه. وأن علاج المرض ليس بسعادة تامة والراحة من
الألم ليست بغاية مطلوبة ولا خير محض. وأن السعيد التام هومن لا يعرض له
مرض البتة. وعرف مع ذلك أيضا أن الملائكة الأبرار الذين اصطفاهم الله
بقربه لا تلحقهم هذه الآلام فلا يحتاجون إلى مداواتها بالأكل والشرب.
وأن
الله تعالى منزه متعال عن هذه الأوصاف - عارضوه بأن بعض البشر أشرف من
الملائكة وأن الله تعالى أجل من أن يذكر مع الخلق. وشاغبوه وسفهوا رأيه
وأوقعوا له شبها باطلة حتى يشك في صحة ما تنبه إليه وأرشده عقله إليه.
والعجب
الذي لا ينقضي هو أنهم مع رأيهم هذا إذا وجدوا واحدا من الناس قد ترك
طريقتهم التي يميلون إليها واستهان باللذة والتمتع وصام وطوى واقتصر على
ما أنبتت الأرض عظموه وكثر تعجبهم منه وأهلوه للمراتب العظيمة. وزعموا انه
ولي الله وصفيه وأنه شبيه بالملك وأنه أرفع طبقة من البشر. ويخضعون له
ويذلون غاية الذل ويعدون أنفسهم أشقياء بالإضافة إليه.
والسبب في ذلك
هو انهم وإن كانوا من أفن الرأي وسفاهته على ما ترى فإن فيهممن تلك القوة
الأخرى الكريمة المميزة وإن كانت ضعيفة ما يريهم فضيلة ذوي الفضائل
فيضطرون إلى إكرامهم وتعظيمهم.
قوى النفس الثلاثاء
وإذا كانت القوى ثلاثا كما قلنا مرارا فأدونها النفس البهيمية. وأوسطها النفس السبعية. وأشرفها النفس الناطقة. والإنسان إنما صار إنسانا بأفضل هذه النفوس أعني الناطقة وبها شارك الملائكة وبها باين البهائم.فأشرف الناس من كان حظه من هذه النفس أكثر وانصرافه إليها أتم وأوفر. ومن غلبت عليه إحدى النفسين الأخريين انحط عن مرتبة الإنسانية بحسب غلبة تلك النفس عليه. فانظر رحمك الله أين تضع نفسك وأين تحب أن تنزل من المنازل التي رتبها الله تعالى للموجودات. فإن هذا أمر موكول إليك ومردود إلى اختيارك. فإن شئت فانزل في منازل البهائم فإنك تكون منهم. وإن شئت فانزل في منازل السباع. وإن شئت فانزل في منازل الملائكة وكن منهم. وفي كل واحدة من هذه المراتب مقامات كثيرة فإن بعض البهائم أشرف من بعض وذلك لقبول التأديب لأن الفرس إنما شرف على الحمار لقبوله الأدب وكذلك في البازي فضيلة على الغراب. وإذا تأملت الحيوان كله وجدت القابل للتأديب الذي هو أثر النطق أعني النفس الناطقة أفضل من سائره وهو يتدرج في ذلك إلى ان يصير إلى الحيوان الذي هو في أفق الإنسان أعني الذي هو أكمل البهائم وهو في أخس مرتبة الإنسانية.
وذلك أن أخس الناس هو من كان قليل العقل قريبا من
البهيمية. وهم القوم الذين في أقاصي الأرض المعمورة وسكان آخر ناحية
الجنوب والشمال لا ينفصلون عن القرود إلا بشيء قليل من التمييز. وبذلك
القدر يستحقون إسم الإنسانية. ثم يتميزون ويتزايدون في هذا المعنى حتى
يبلغوا إلى وسط الأقاليم، ويعتدل فيهم المزاج القابل لصورة العقل فيصير
فيهم العاقل التام والمميز العالم. ثم يتفاضلون في هذا المعنى أيضا إلى أن
يصيروا إلى غاية ما يمكن للإنسان أن يبلغ إليه من قبول قوة العقل والنطق.
فيصير حينئذ في الأفق الذي بين الإنسان والملك ويصير فيهم القابل للوحي
والمطليق لحمل الحكمة فتيض عليه قوة العقل ويسيح إليه نور الحق ولا حالة
للإنسان أعلى من هذه ما دام إنسانا.
ثم ارجع القهقري إلى النظر في
الرتبة الناقصة التي هي أدون مراتب الإنسان فإنك تجد القوم الذين تضعف
فيهم القوة الناطقة وهم القوم الذي ذكرنا أنهم في أفق البهائم تقوى فيهم
النقص البهيمية فيميلون إلى شواتها المأخوذة بالحواس كالمأكول والمشروب
والملبوس وسائر النزوات الشبيهة بها. وهؤلاء هم الذين تجذبهم الشهوات
القوية بقوة نفوسهم البهيمية حتى يرتكبونها ولا يرتدعوا عنها. وبقدر ما
يكون فيهم من القو العاقلة يستحيون منها تى يستتروا بالبيوت ويتواروا
بالظلمات إذا هموا بلذة تخصهم.
وهذا الحياء منهم هو الدليل على قبحها
فإن الجميل بالإطلاق هو الذي يتظاهربه ويستحب إخراجه وإذاعته. وهذا القبح
ليس بشيء أكثر من النقصانات اللازمة للبشر. وهي التي يشتاقون إلى إزالتها.
وافحشها هو انقصها. و انقصها أحوجها إلى الستر والدفن. ولو سألت القوم
الذين يعظمون أمر اللذة ويجعلونها الخير المطلوب والغاية الإنسانية لم
تكتمون الوصول إلى أعظم الخيرات عندكم. وما بالكم تعدون موافقتها خيرا ثم
تسترونها؟ أترون سترها وكتمانها فضيلة ومروءة وإنسانية والماهجرة بها
وإظهارها بين أهل الفضل وفي مجمع الناس خساساة وقحة؟ - لظهر من انقطاعهم
وتبلدهم في الجواب ما تعلم به سوء مذهبهم وخبث سيرتهم. وأقلهم حظا من
الإنسانية إذا رأى إنسانا فاضلا احتشمه ووقره وأحب أن يكون مثله إلا الشاذ
منهم الذي يبلغ من خساسة الطبع ونزارة الإنسانية ووقاحة الوجه إلى أن يقيم
على نصرة ما هو عليه من غير محبة لرتبة من أفضل منه.
الواجب على العاقل
فإذا
يجب على العاقل أن يعرف ما ابتلى به الإنسان من هذه النقائص التي في جسمه
وحاجاته الضرورية إلى إزالتها وتكميلها، أما بالغذاء الذي يحفظ به إعتدال
مزاجه وقوام حياته فينال منه قدر الضرورة في كماله. ولا يطلب اللذة لعينها
بل قوام الحياة التي تتبعه اللذة. فإن تجاوز ذلك قليلا فبقدر ما يحفظ
رتبته في مروءته. ولا ينسب إلى الدناءة والبخل بحسب حاله ومرتبته بين
الناس، وأما باللباس فالذي يدفع به أذى الحر والبرد ويستر العورة. فإن
تجاوز ذلك فبقدر ما لا يستحقر ولا ينسب إلى الشح على نفسه وإلى أن يسقط
بين أقرانه وأهل طبقته، وأما بالجماع فالذي يحفظ نوعه وتبقى به صورته،
أعني طلب النسل فإن تجاوز ذلك فبقدر مالا يخرج به عن السنة ولا يتعدى ما
يملكه إلى ما يملك غيره ثم يلتمس الفضيلة في نفسه العاقلة التي بها صار
إنسانا وينظر إلى النقائص التي في هذه النفس خاصة فيروم تكميلها بطاقته
وجهده. فإن هذه الخيرات هي التي لا تستر وإذا وصل إليها لا يمنع عنها
الحياء ولا يتوارى عنها بالحيطان والظلمات ويتظاهر بها أبدا بين الناس وفي
المحافل. وهي التي يكون بها بعض الناس أفضل من بعض وبعضهم أكثر إنسانية من
بعض ويغذوا هذه النفس بغذائها الموافق لها المتم لنقصانها كما يغذو تلك
بأغذيتها الملائمة لها. فإن غذاء هذه هو العلم والزيادة في المعقولات
والإرتياض بالصدق في الآراء وقبول الحق حيث كان ومع من كان والنفور من
الكذب والباطل كيف كان ومن أين جاء. فمن اتفق له في الصبا أن يربي على أدب
الشريعة ويؤخذ بوظائفها وشرائطها حتى يتعودها ثم ينظر بعد ذلك في كتب
الأخلاق حتى تتأكد تلك الآداب والمحاسن في نفسه بالبراهين. ثم ينظر في
الحساب والهندسة حتى يتعود صدق القول وصحة البرهان فلا يسكن إلا إليها ثم
يتدرج (كما رسمناه في كتابنا الموسوم بترتيب السعادات ومنازل العلوم) حتى
يبلغ إلى أقصى مرتبة الإنسان فهو السعيد الكامل فليكثر حمد الله تعالى على
الموهبة العظيمة والمنة الجسيمة. ومن لم يتفق له ذلك في مبدأ نشوه ثم
ابتلى بأن يربيه والده على رواية الشعر الفاحش وقبول أكاذيبه واستحسانا ما
يوجد فيه من ذكر القبائح ونيل اللذات كما يوجد في شعر امرىء القيس
والنابغة وأشباههما ثم صار بعد ذلك إلى رؤساء يقرونه على روايتها وقول
مثلها ويجزلون له العطية.
وامتحن بأقران يساعدونه على تناول اللذات
الجسمانية. ومال طبعه إلى الإستكثار من المطاعم والملابس والمراكب والزينة
وإرتباط الخيل الفره والعبيد الروقة (كما اتفق لي مثل ذلك في بعض الأوقات)
ثم انهمك فيها واشتغل بها عن السعادة التي أهل لها - فليعد جميع ذلك شقاء
لا نعيما وخسرانا لا ربحا وليجتهد على التدريج إلى فطام نفسه منها. وما
أصعب إلا أنه على كل حال غير من التمادي في الباطل. وليعلم الناظر في هذا
الكتاب إن خاصة تدرجت إلى فطام نفسي بعد الكبر واستحكام العادة وجاهدتها
جهادا عظيما.
ورضيت لك أيها الفاحص عن الفضائل والطالب للأدب الحقيقي
بما رضيت لنفسي بل تجاوزت لك في النصيحة إلى أن أشرت عليك بما فاتني في
ابتداء أمري لتدركه أنت. ودللتك على طريق النجاة قبل أن تتيه في مفاوز
الضلالة وقدمت لك السفينة قبل أن تغرق في بحر المهالك. فالله الله في
نفوسكم معاشر الإخوان والأولاد. إستسلموا للحق وتأدبوا بالأدب الحقيقي لا
المزور وخذوا الحكمة البالغة وانتهجوا الصراط المستقيم وتصوروا حالات
أنفسكم وتذكروا قواها. وأعلموا أن أصح مثل ضرب لكم من نفوسكم الثلاث التي
مر ذكرها في المقالة الأولى: مثل ثلاثة حيوانات مختلفة جمعت في مكان واحد
ملك وسبع وخنزير. فأيها غلب بقوته قوة البالقين كان الحكم له. وليعلم من
تصور هذا المثال أن النفس لما كانت جوهرا غير جسم ولا شيء فيها من قوى
الجسم وأعراضه كما بينا ذلك في صدر هذا الكتاب كان اتحادها واتصالها بخلاف
اتحاد الأجسام وإتصال بعضها ببعض.
النفوس الثلاثاء وذلك أن هذه الأنفس الثلاث إذا اتصلت صارت شيئا واحدا
ومع أنها تكون شيئا واحدا فهي باقية التغاير وباقية القوى تثور الواحدة بعد الواحدة حتى كأنها لم تصل بالأخرى ولم تتحد بها وتستجدي أيضا الواحدة للأخرى حتى كأنها غير موجودة ولا قوة لها تنفرد بها. وذلك أن إتحادها ليس بأن تتصل نهايتها ولا بأن تتلقى سطوحها كما يكون ذلك في الأجسام. بل تصير في بعض الأحوال شيئا واحدا وفي بعض الأحوال أشياء مختلفة بحسب ما تهيج قوة بعضها أو تسكن. ولذلك قال قوم أن النفس واحدة ولها قوى كثيرة. وقال آخرون بل هي واحدة بالذات كثيرة بالعرض وبالموضوع.وهذا شيء يخرج الكلام فيه عن غرض الكتاب وسيمر بك في موضعه.
وليس يضرك في هذا الوقت أن تعتقد أي هذه الآراء شئت بعد أن تعلم أن بعض هذه كريمة أدبية بالطبع وبعضها مهينة عادمة للأدب بالطبع. وليس فيها استعداد لقبول الأدب وبعضها عادمة للأدب. إلا انها تقبل التأدب وتنقاد للتي هي أدبية. أما الكريمة الأدبية بالطبع فالنفس الناطقة. وأما العادمة للأدب وهي مع ذلك غير قابلة له فيه النفس البهيمية وأما التي عدمت الأدب ولكنها تقبله وتنقاد له فهي النفس الغضبية وإنما وهب الله تعالى لنا هذه النفس خاصة لنستعين بها على تقويم البهيمية التي لا تقبل الأدب. وقد شبه القدماء الإنسان وحاله في هذه الأنفس الثلاث بإنسان راكب دابة قويى يقود كلبا أو فهدا للقنص.
فإن كان الإنسان من بينهم هوالذي يروض دابته وكلبه يصرفهما ويطيعانه في سيره وتصيده وسائر تصرفاته فلا شك في رغد العيش المشترك بين الثلاث وحسن أحواله. لأن الإنسان يكون مرفها في مطالبه يجري فرسه حيث يحب وكما يحب ويطلق كلبه أيضا كذلك. فإذا نزل واستراح أراحهما معه وأحسن القيام عليهما في المطعم والمشرب وكفاية الأعداء وغير ذلك من مصالحهما. وإذا كانت البهيمية هي الغالبة ساءت حال الثلاثة وكان الإنسان مضعوفا عندهما فلم تطع فارسها وغلبت. فإن رأت عشبا من بعيد عدت نحوه وتعسفت في عدوها وعدلت عن الطريق النهج فاعترضتها الأودية والوهاد والشوك والشجر فتقحمتها وتورطت فيها ولحق فارسها ما يلحق مثله في هذه الأحوال فيصيبهم جميعا من أنواع المكاره والإشراف على الهلكة ما خفاء فيه.
وكذلك أن قوى الكلب لم يطع صاحبه فإن رأى من بعيد صيدا أو ما يظنه صيدا أخذ نحوه فجذب الفارس وفرسه ولحق الجميع من الضرر والضر أضعاف ما ذكرناه. وفي تصور هذا المثل الذي ضربه القدماء تنبيه على حال هذه النفوس ودلالة على ما وهبه الله عز وجل للإنسان ومكنه منه وعرضه له وما يضيعه بعصيان خالقه تعالى فيه عند إهمال السياسة واتباعه أمر هاتين القوتين وتعيده لهما وهما اللذان ينبغي أن يتبعاه بتأمره عليهما. فمن اسوأ حالا ممن اهمل سياسة الله عز وجل وضيع نعمته عليه ترك هذه القوى فيه هائجة مضطربة تتغلب. وصار الرئيس منها مرؤوسا والملك منها مستعبدا يتقلب معها في المهالك حتى تتمزق ويتمزق معها هو أيضا. نعوذ بالله من الإنتكاس في الخلق الذي سببه طاعة الشيطان واتباع الأبالسة فليست الإشارة بها إلى غير هذه القوى التي وصفناها ووصفنا أحوالها. نسأل الله عصمته ومعونته على تهذيب هذه النفوس حتى ننتهي فيها إلى طاعة الله التي هي نهاية مصالحنا وبها نجاتنا وخلاصنا إلى الفوزالأكبر والنعيم السرمدي.
سياسة النفس العاقلةوقد شبه الحكماء من أهمل سياسة نفسه العاقلة وترك سلطان الشهوة يستولي عليها برجل معه ياقوتة حمراء شريفة لا قيمة لها من الذهب والفضة جلالة ونفاسة. وكان بين يديه نار تضطرم فرماها في حباحبها حتى صارت كاسا لا منفعة فيها فخسرت فخسرت منافعها. فقد علمنا الآن أن النفس العاقلة إذا عرفت شرف نفسها وأحست بمرتبتها من الله عزوجل أحسنت خلافته في تربية هذه القوى وسياستها ونهضت بالقوة التي أعطاها الله تعالى إلى محلها من كرامة الله تعالى ومنزلتها من العلو والشرف ولم تخضع للسبعية ولا للبهيمية.
بل تقوم النفس الغضبية
التي سميناها سبعية ونقودها إلى الأدب بحملها على حسن طاعتها. ثم تستنهضها
في أوقات هيجان هذه النفس البهيمية وحركتها إلى الشهوات حتى يقمع بهذه
سلطان تلك وتستخدمها في تأديبها وتستعين بقوة هذه على تأبى تلك. وذلك أن
هذه النفس الغضبية قابلة للأدب قوية على قمع الأخرىكما ن. وتلك النفس
البهيمية عادمة للأدب غير قابلة له. وأما النفس الناطقة أعني العاقلة فهي
كمال قال أفلاطون بهذه الألفاظ: أما هذه فبمنزلة الذهب في اللين
والإنعطاف. وأما تلك فبمنزلة الحديد في الصلابة والإمتناع فإن أنت آثرت
الفعل الجميل في وقت وجاذبيتك القوة الأخرى إلى اللذة وإلى خلاف ما ىثرت
الفعل الجميل في وقت وجاذبيتك القوى الأخرى إلى اللذة وإلى خلاف ما آثرت
فاستعن بقوة الغضب التي تثير وتهيج بالأنفة والحمية وأقهر بها النفس
البهيمية. فإن غلبتك مع ذلك ثم ندمت وأنفت فأنت في طريق الصلاح فتمم
عزيمتك واحذر أنت أن تعاودك بالطمع فيك والغلبة لك؟ فإن لم تفعل ذلك ولم
تكن العقبة في الغلبة لك كنت كما قال الحكيم الأول: إني أرى أكثر الناس
يدعون محبة الفعال الجميلة ثم لا يحتملون المؤنة فيها على علمهم بفضلها
فيغلبهم الترفه ومحبة البطالة. فلا يكون بينهم وبين من لا يحب الأفعال
الجميلة فرق إذا لم يحتملوا مؤنة الصبر ويصبروا إلى تعلم تمام ما آثروه
وعرفوا فضله. واذكر مثل البئر التي تردى فيها الأعمى والبصير فيكونان في
الهلكة سواء إلا أن الأعمى أعذر. ومن وصل من هذه الآداب إلى مرتبة يعتد
بها واكتسب بها الفضائل التي عددنها فقد وجب عليه تأديب غيره وإفاضة ما
أعطاه الله على أبناء جنسه.
فصل في تأديب الأحداث والصبيان خاصة نقلت أكثره من كتاب بروسنس
قد
قلنا فيما تقدم أن أول قوة تظهر في الإنسان وأول ما يتكون هي القوة التي
يشتاق بها إلى الغذاء الذي هو سبب كونه حيا فيتحرك بالطبع إلى اللبن
يلتمسه من الثدي الذي هو معدنه من غير تعليم ولا توقيف أو يحدث له مع ذلك
قوة على التماسه بالصوت الذي هو مادته ودليله الذي يدل به على اللذة
والأذى. ثم تتزايد فيه هذه القوة ويتشوق بها أبدا إلى الإزدياد والتصرف
بها في أنواع الشهوات. ثم تحدث فيه قوة على التحرك نحوها بالآلات التي
تخلق له الشوق إلى الأفعال التي تحصل له هذه. ثم يحدث له من الحواس قوة
على تخيل الأمور ويرتسم في قوته الخيالية مثالات فيتشوق إليها ثم تظهر فيه
قوة الغضب التي يشتاق بها إلى دفع ما يؤذيه ومقاومة ما يمنعه من منافعه.
فإن أطاق بنفسه أن ينتقم من مؤذياته انتقم منها وإلا التمس معونة غيره
وانتصر بوالديه بالتصويت والبككاء. ثم يحدث له الشوق إلى تمييز الأفعال
الإنسانية خاصة أولا أولا حتى يصير إلى كماله في هذا التمييز فيسمى حينئذ
عاقلا. وهذه القوى كثيرة وبعضها ضروري في وجود الأخرى إلى أن ينتهي إلى
الغاية الأخيرة. وهي التي لا تراد لغاية أخرى وهو الخير المطلق الذي
يتشوقه الإنسان من حيث هو إنسان. فأول ما يحدث فيه من هذه القوة الحياء
وهو الخوف من ظهور شيء قبيح منه. ولذلك قلنا أول ما ينبغي أن يتفرس
فيالصبي ويستدل به على عقله. الحياء فإنه يدل على أنه قد أحس بالقبيح ومع
إحساسه به يحذره ويتجنبه ويخاف أن يظهر منه أو فيه. فإذا نظرت إلى الصبي
فوجدته مستحيينا مطرقا بطرفه إلى الأرض غير وقاح الوجه ولا محدق اليك فهو
أول دليل نجابته والشاهد لك على أن نفسه قد أحست بالجميل والقبيح. وأن
حياءه هو انحصار نفسه خوفا من قبيح يظهر منه وهذا ليس بشيء أكثر من إيثار
الجميل والهرب من القبيح بالتمييز والعقل. وهذه النفس مستعدة للتأديب
صالحة للعناية لا يجب أن تهمل ولا تترك ومخالطة الأضداد الذين يفسدون
بالمقارنة والمداخلة. وإن كانت بهذه الحال من الإستعداد لقبول الفضيلة فإن
نفس الصبي ساذجة لم تنتقش بعد بصرة وليس لها رأي ولا عزيمة تميلها من شيء
إلى شيء فإذا نقشت بصورة وقبلتها نشأ عليها وأعتادها. فالأولى بمثل هذه
النفس أن تنبه أبدا على حب الكرامة ولا سيما ما يحصل له منها بالدين دون
المال وبلزوم سننه ووظائفه. ثم يمدح الأخيار عنده ويمدح هو في نفسه إذا
ظهر شيء جميل منه ويخوف من المذمة على أدنى قبيح يظهر منه ويؤاخذ باشتهائه
للمآكل والمشارب والملابس الفاخرة ويزين عنده خلق النفس والترفع عن الحرص
في المآكل خاصة وفي اللذات عامة. ويجب إليه إيثار غيره على نفسه بالغذاء
والإقتصار على لاشيء المعتدل والإقتصاد في التماسه.
الملابس
ويعلم أن أولى الناس بالملابس الملونة والمنقوشة النساء اللاتي يتزين للرجال ثم العبيد والخول. وأن الأحسن بأهل النبل والشرف من اللباس البياض وما أشبهه حتى يتربى على ذلك ويسمعه كل من يقرب منه ويتكرر عليه ولم يترك مخالطة من يسمع منه ضد ما ذكرته لا سيما من أترابه ومن كان في مثل سنه ممن يعاشره ويلاعبه.وذلك أن الصبي في ابتداء نشوه يكون على الأكثر قبيح الأفعال
إما كلها وإما اكثرها فإنه يكون كذوبا ويخبر ويحكي ما لم يسمعه ولم يره
ويكون حسودا سروقا نماما لجوجا ذا فضول أضر شيء بنفسه وبكل أمر يلابسه. ثم
لا يزال به التأديب والسنن والتجار حتى ينتقل في أحوال بعد أحوال. فلذلك
ينبغي أن يؤخذ ما دام طفلا بما ذكرناه وبذكره. ثم يطالب بحفظ محاسن
الأخبار والأشعار التي تجري مجرى ما تعوده بالأدب حتى يتأكد عنده بروايتها
وحفظها والمذاكرة بها جميع ما قدمناه ويحذر النظر في الأشعار السخيفة وما
فيها من ذكر العشق وأهله وما يوهمه أصحابها، إنه ضرب من الظرف ورقة الطبع.
فإن هذا الباب مفسدة للأحداث جدا. ثم يمدح بكل ما يظهر منه من خلق جميل
وفعل حسن ويكرم عليه. فإن خالف في بعض الأوقات ما ذكرته فالأولى أن لا
يوبخ عليه ولا يكاشف بأنه أقدم عليه بل يتغافل عنه تغافل من لا يخطر بباله
أنه قد تجاسر على مثله ولا هم به لا سيما أن ستره الصبي واجتهد في أن يخفى
ما فعله عن الناس فإن عاد فليوبخ عليه سرا وليعظم عنده ما أتاه. ويحذر من
معاودته فإنك إن عودته التوبيخ والمكاشفة حملته على الوقاحة وحرضته على
معاودة ما كان استقبحه وهان عليه سماع الملامة في ركوب قبائح اللذات التي
تدعو إليها نفسه وهذه اللذات كثيرة جدا.
آداب المطاعم
والذي ينبغي أن يبدأ به في تقويمها آداب المطاعم فيفهم أولا انها إنما تراد للصحة لا للذةز وأن الأغذية كلها إنما خلقت وأعدت لنا لتصح بها أبداننا وتصير مادة حياتنا. فهي تجري مجرى الأدوية ليتداوي بها الجوع والألم الحادث منه. فكما أن الدواء لا يرام للذة ولا يستكثر منه للشهوة فكذلك الأطعمة لا ينبغي أن يتناول منها إلا ما يحفظ صحة البدن ويدفع ألم الجوع ويمنع من المرض. فيحفر عنده قدر الطعام الذي يستعظمه أهل الشره ويقبح عنده صورة من شره غليه وينال منه فوق حاجة بدنه أو مالا يوافقه حتى يقتصر على لون واحد. ولا يرغب في الألوان الكثيرة. وإذا جلس مع غيره لا يبادر إلى الطعام ولا يديم النظر إلى ألوانه ولا يحدق إليه شديدا. ويقتصر على ما يليه ولا يسرع في الأكل ولا يوالي بين اللقم بسرعة. ولا يعظم اللقمة ولا يبتلعها حتى يجيد مضغها. ولا يلطخ يده ولا ثوبه ولا يلحظ من يؤاكله ولا يتبع بنظره مواقع يده من الطعام. ويعود أن يؤثر غيره بما يليه إن كان أفضل ما عنده ثم يضبط شهوته حتى يقتصر على أدنى الطعام وأدونه. ويأكل الخبز القفار الذي لا أدم معه في بعض الأوقات وهذه الآداب وإن كانت جميلة بالفقراء فهي بالأغنياء أفضل وأجمل. وينبغي أن يستوفي غذاه بالعشي فإن استوفاه بالنهار كسل واحتاج إلى النوم وتبلد فهمه مع ذلك. وإن منع اللحم في أوقاته كان أنفع له وقعا في الحركة والتيقظ وقلة البلادة وبعثه على النشاط والخفة. وأما الحلواء والفاكهة فينبغي أن يمتنع منها ألبتة إن أمكن. وإلا فليتناول أقل ما يمكن فإنها تستحيل في بدنه فتكثر إنحلاله وتعوده مع ذلك على الشره ومحبة الإستكثار من المآكل. ويعود أن لا يشرب في خلال طعامه الماء. فإما النبيذ وأصناف الأشربة المسكرة فإياها وإياها فإنها تضره في بدنه ونفسه وتحمله على سرعة الغضب والتهور والإقدام على القبائح والقحة وسائر اخلال المذمومة.آداب متنوعةولا ينبغي أن يحضر مجالس أهل الشرب إلا أن يكون أهل المجلس أدباء فضلاء. وأما غيرهم فلا لئلا يسمع الكلام القبيح والسخافات التي تجري فيه.
وينبغي أن لا يأكل حتى يفرغ من وظئاف الأدب التي يتعملها ويتعب تعبا كافيا. وينبغي أن يمنع من كل فعل يستره. ويخنفيه فإنه ليس يخفى شيئا إلا وهو يظن أو يعلم أنه قبيح. يومنع من النوم الكثير فإنه يقبحه ويغلظ ذهنه ويميت خاطره. هذا بالليل فأما بالنهار فلا ينبغي أن يتعوده ألبتة. ويمنع أيضا من الفراش الوطيء وميع أنواع الترفه حتى يصلب بدنه ويتعود الخشونة ولا يتعود الخيش والأسراب في الصيف ولا الأوبار والنيران في الشتاء للأسباب التي ذكرناها. ويعود المشي والحركة والركوب والرياضة حتى لا يتعود أضدادها.
ويعود أن
لا يكشف أطرافه ولا يسرع في المشي ولا يرخي يديه بل يضمهما إلى صدره ولا
يربي شعره. ولا يزين بملابس النساء ولا يلبس خاتما إلا وقت حاجته إليه.
ولا يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والداه من مآكله وملابسه وما يجري
مجراه ولا يشين بل يتواضع لكل أحد ويكرم كل من عاشره.
ولا يتوصل بشرف
إن كان له أو سلطان من أهله إن اتفق إلى غضب من هو دونه أو استهداء من لا
يمكنه أن يرده عن هواه أو تطاوله عليه. كمن اتفق له إن كان خاله وزيرا أو
عمه سلطانا فتطرق به إلى هضيمة أقرانه وثلم أخوانه ولا يتمخط ولا يتثاءب
بحضرة غيره. ولا يضع رجلا على رجل ولا يضرب تحت ذقنه بساعده ولا يعمد رأسه
بيده. فإن هذا دليل الكسل وأنه قد بلغ به القبيح إلى أن لا يحمل رأسه حتى
يستعين بيده. ويعود أن لا يكذب ولا يحلف البتة لا صادقا ولا كاذبا. فإن
هذا قبيح بالرجال مع الحاجة إليه في بعض الأوقات فأما الصبي فلا حاجة به
إلى اليمين. ويعود أيضا قلة الكلام فلا يتكلم إلا جوابا. وإذا حضر من هو
أكبر منه اشتغل بالاستماع منه والصمت له. ويمنع من خبيث الكلام وهجينه ومن
السب واللعن ولغو القول. ويعود حسن الكلام وظريفه وجميل اللقاء وكريمه ولا
يرخص له أن يستمع لاضدادها من غيره. ويعود خدمة نفسه ومعلمه وكل من كان
أكبر منه.
وأحوج الصبيان إلى هذا الأدب أولاد الأغنياء والمترفين.
وينبغي إذا ضربه المعلم أن لا يصرخ ولا يستشفع بأحد فإن هذا فعل المماليك
ومن هو خوار ضعيف. ولا يعير أحدا إلا بالقبيح والسيء من الأدب. ويعود أن
لا يوحش الصبيان. بل يبرهم ويكافئهم على الجميل بأكثر منه لئلا يتعود
الريح على الصبيان وعلى الصديق. ويبغض إليه الفضة والذهب ويحذر منهما أكثر
من تحذير السباع والحيات والعقارب والأفاعي. فإن حب الفضة والذهب آفته
أكثر من آفات السموم. وينبغي أن يؤذن له في بعض الأوقات أن يلعب لعبا
جميلا ليستريح إليه من تعب الأدب ولا يكون في لعبه ألم ولا تعب شديد.
ويعود
طاعة والديه ومعلميه ومؤديه وإن ينظر اليهم بعين الجلالة والتعظيم
ويهلبهم. وهذه الآداب النافعة للصبيان هي للكبار من الناس أيضا نافعة
ولكنها للأحداث أنفع لأنها تعودهم محبة الفضائل وينشأون عليها فلا يثقل
عليهم تجنب الرذائل ويسهل عليهم بعد ذلك جمثيع ما ترسمه الحكمة وتحده
الشريعة والسنة. ويعتادون ضبط النفس عما تدعوهم إليه من الذات القبيحة
وتكفهم عن الإنهماك في شيء منها والفكر الكثير فيها. وتسوقهم إلى مرتبة
الفلسفة العالية وترقيهم إلى معالي الأمور التي وصفناها في أول الكتاب من
التقرب إلى الله عز وجل ومجاورة الملائكة مع حسن الحال في الدنيا وطيب
العيش وجميل الأحدوثة وقلة الأعداء وكثرة المداح والراغبين في مودته من
الفضلاء خاصة. فإذا تجاوز هذه الرتبة وبلغ أيامه إلى أن يفهم أغراض الناس
وعواقب الأمور فهم أن الغرض الأخير من هذه الأشياء التي يقصدها الناس
ويحرصون عليها من الثروة وإقتناء الضياع والعبيد والخيل والفرش وأشباه ذلك
إنما هو لنر فيه البدن وحفظ صحته. وأن يبقى على إعتداله مدة ما. وأن لا
يقع في الأعراض ولا تفجأه المنية. وأن يهنأ بنعمة الله عليه ويستعد لدار
البقاء والحياة السرمدية. وأن اللذات كلها في الحقيقة هي خلاص من آلام
وراحات من تعب. فإذا عرف ذلك وتحققه ثم تعوده بالسيرة الدائمة وعود
الرياضات التي تحرك الحرارة الغريزية وتحفظ الصحة وتنفي الكسل وتطرد
البلادة وتبعث النشاط وتذكي النفس. فمن كان ممولا مترفا كانت هذه الأشياء
التي رسمتها أصعب عليه لكثرة من يحتف به ويغويه ولموافقة طبيعة الإنسان في
أول ما تنشأ هذه اللذات وإجماع جمهور الناس على نيل ما أمكنهم منها وطلب
ما تعذر عليهم بغاية جهدهم. فأما الفقراء فالأمر عليهم أسهل بل هم قريبون
إلى الفضائل قادرون عليها متمكنون من نيلها والإصابة منها. وحال المتوسطين
من الناس متوسطة بين هاتين الحالتين. وقد كان ملوك الفرس الفضلاء لا يربون
أولادهم بين حشمهم وخواصهم خوفا عليهم من الأحوال التي ذكرناها ومن سماع
ما حذرت منه. وكانوا ينفذونهم مع ثقاتهم إلى النواحي البيعدة منهم. وكان
يتولى تربيتهم أهل الجفاء وخشونة العيش ومن لا يعرف التنعم ولا الترفه
وأخبارهم في ذلك مشهورة. وكثير من رؤسائهم في زماننا هذا ينقولن أولادهم
عندما ينشأون إلى بلادهم ليتعودوا بها هذه الطرق المحمودة في تأديب
الأحداث فقد عرفت أضدادها. أعني أن يشتغل بصلاحه وتقويمه فإنه قد صار
بمنزلة الخنزير الوحشي الذي لا يطمع في رياضته فإن نفسه العاقلة تصير
خادمة لنفسه البهيمية ولنفسه الغضبية فهي منهمكة في مطالبها من النزوات.
وكما أنه لا سبيل إلى رياضة سباع البهائم الوحشية التي لا تقبل التأديب
كذلك لا سبيل إلى رياضة من نشأ على هذه الطريقة واعتادها وأمعن قليلا في
السن. اللهم إلا أن يكون في جميع أحواله عالما بقبح سيرته ذا مالها عائبا
على نفسه عازما على الإقلاع والإنابة. فإن مثل هذا الإنسان من يرجى له
النزوع عن أخلاقه بالتدريج والرجوع إلى الطريقة المثلى بالتوبة وبمصاحبةب
الأخيار وأهل الحكمة وبالأكباب على التفلسف. وإذ قد ذكرنا الخلق المحمود
وما ينبغي أن يؤخذ به الأحداث والصبيان فنحن واصفون جميع القوى التي تحدث
لليحوان أولا أولا إلى أن ينتهي إلى أقصى الكمال في الإنسانية فإنك شديد
الحاجة إلى معرفة ذلك لتبتديء على الترتيب الطبيعي في تقويم واحد منها
فنقول:
الأجسام الطبيعية
إن الأجسام الطبيعية كلها تشترك في الحد الذي يعمها ثم تتفاضل بقبول الآثار الشريفة والصور التي تحدث فيها. فإن الجماد منها إذا قبل صورة مقبولة عند الناس صار بها أفضل من الطينة الأولى التي لا تقبل تلك الصورة. فإذا بلغ إلى أن يقبل صورة النبات صار بزيادة هذه الصورة أفضل من الجماد.وتلك الزيادة هي الإغتذاء
والنمو والإمتداد في الإقطار وإجتذاب ما يوافقه من الأرض والماء وترك ما
لا يوافقه ونفض الفضلات التي تتولد فيه من غذائه عن جسمه بالصموغ. وهذه
الأشياء التي ينفصل بها النبات من الجماد. وهذه الحالة الزائدة في النبات
التي شرف بها على الجماد تتفاضل: وذلك أن بعضه يفارق الجماد مفارقة يسيرة
كالمرجان وأشباهه. ثم يتدرج فيها فيحصل له من هذه الزيادة شيء بعد شيء
فبعضه ينبت من غير زرع ولا بذر ولا يحفظ نوعه بالثمر والبزر. ويكفيه في
حدوثه امتزاج العناصر وهبوب الرياح وطلوع الشمس فلذلك هو في أفق الجمادات
وقريب الحال منها. ثم تزداد هذه الفضيلة في النبات فيفضل بعضه على بعض
بنظام وترتيب حتى تظهر فيه قوة الأثمار وحفظ النوع بالبزر الذي يخلف به
مثله فتصير هذه الحالة زائدة فيه ومميزة له عن حال ما قبله. ثم تقوى هذه
الفضيلة فيه حتى يصير بعضه على بعض حتى يبلغ إلى أفقه ويصير في أفق
الحيوان. وهي كرام الشجر كالزيتون والرمان والكرم وأصناف الفواكه إلا أنها
بعد مختلطة القوى أعني أن قوى ذكورها وإناثها غير متميزة فهي تحمل وتلد
المثل ولم تبلغ غاية أفقها الذي يتصل بأفق الحيوان. ثم تزداد وتمعن في هذا
الأفق إلى ان تصير في أفق الحيوان فلا تحتمل زيادة. وذلك أنها أن قبلت
زيادة يسيرة صارت حيوانا وخرجت عن أفق النبات. فحينئذ تتميز قواها ويحصل
فيها ذكورة وأنوثة وتقبل من فضائل الحيوان أمورا تتيمز بها عن سائر النبات
والشجر كالنخل الذي طالع أفق الحيوان بالخواص العشر المذكورة في مواضعها
ولم يبق بينه وبين الحيوان إلا مرتبة واحدة وهي الإنقلاع من الأرض والسعي
إلى الغذاء. وقد روى في الخبر ما هو كالإشارة أو كالرمز إلى هذا المعنى
وهو قوله صلى الله عليه وسلم: {أكرموا عماتكم النخل فإنها خلقت من بقية
طينة آدم} فإذا تحرك النبات وانقلع من أفقه وسعى إلى غذائه ولم يتقيد في
موضعه إلى أن يصير إليه غذاؤه وكونت له آلات أخر يتناول بها حاجاته التي
تكمله فقد صار حيوانا.
وهذه الآلات تتزايد في الحيوان من أول أفقه
وتتفاضل فيه فيشرف فيه بعضها على بعض كما كان ذلك في النبات فلا يزال يقبل
فضيلة بعد فضيلة حتى تظهر فيه قوة الشعور باللذة والأذى فيلتذ بوصوله إلى
منافعه ويتألم بوصول مضاره إليه. ثم يقبل الهام الله عز وجل إياه فيهتدي
إلى مصالحه فيطلبها وإلى أضداده فيهرب منها. وما كان من الحيوان في أول
أفق النبات فإنه لا يتزاوج ولا يخلف المثل بل يتوالد كالديدان والذباب
وأصناف الحشرات الخسيسة.
ثم يتزايد فيه قبول الفضيلة كما كان في النبات
سواء. ثم تحدث فيه قوة الغضب التي ينهض بها إلى دفع ما يؤذيه فيعطي من
السلاح بحسب قوته وما يطيق استعماله. فإن كانت قوته الغضبية شديدة كان
سلاحه تاما قويا. وإن كانت ناقصة كان ناقصا وإن كانت ضعيفة جدا لم يعط
سلاح ألبتة بل أعطى آلة الهرب كشدة العدو والقدوة على الحيل التي تنجيه من
مخاوفه. وأنت ترى ذلك عيانا من الحيوان الذي أعطى القرون التي تجري له
مجرى الرماح.
والذي أعطى الأنياب والمخالب التي تجري له مجرى السكاكين
والخناجر. والذي أعطى آلة الرمى التي تجري له مجرى النبل والنشاب. والذي
اعطى الحوافر التي تجري له مجرى الدبوس والطبرزين. فأما ما لم يعط سلاحا
لضعفه عن استعماله ولقلة شجاعته ونقصان قوته الغضبية ولأنه لو أعطيه لصار
كلا عليه فقد أعطى آلة الهرب والحيل بجودة العدو والخفة والختل والمراوغة
كالأرانب وأشباهها. وإذا تصفحت أحوال الموجودات من السباع والوحش والطير
رأيت هذه الحكمة مستمرة فيها فتبارك الله أحسن الخالقين لا إله إلا هو
فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، فأما الإنسان فقد عوض من
هذه الآلات كلها بان هدى إلى استعمالها كلها وسخرت هذه كلها له وسنتكلم
على ذلك في موضعه. فأما أسباب هذه الأشياء كلها والشكوك التي تعترض في قصد
بعضها بعضا بالتلف والأنواع من الأذى فليس يليق بهذا الموضع وسأذكرها أن
أخر الله في الأجل عند بلوغنا إلى الموضع الخاص بها.
مراتب الحيوان
ونعود
إلى ذكر مراتب الحيوان فنقول: أن ما أهدى منها إلى الإزدواج وطلب النسل
وحفظ الولد وتربيته والإشفاق عليه بالكن والعش واللباس كما نشاهد فيما يلد
ويبيض وتغذيته إما باللبن وإما بنقل الغذاء إليه فإنه أفضل مما لا يهتدي
إلى شيء منها. ثم لا تزال هذه الأحوال تتزايد في الحيوان حتى يقرب من أفق
الإنسان فحينئذ يقبل التأديب ويصير بقبوله للأدب ذا فضيلة يتميز بها من
سائر الحيوانات. ثم تتزايد هذه الفضيلة في الحيوانات حتى يشرف بها ضروب
الشرف كالفرس والبازي المعلم. ثم يصير من هذه المرتبة إلى مرتبة الحيوان
الذي يحاكي الإنسان من تلقاء نفسه ويتشبه به من غير تعليم كالقردة وما
أشبهها ويبلغ من ذكائها ن تستكفي في التأدب بأن ترى الإنسان يعمل عملا
فتعمل مثله من غير أن تحوج الإنسان إلى تعب بها ورياضة لها وهذه غاية أفق
الحيوان التي أن تجاوزها وقبل زيادة يسيرة خرج بها عن أفقه وصار في أفق
الإنسان الذي يقبل العقل والتمييز والنطق والآلات التي يستعملها والصور
التي تلائمها. فإذا بلغ هذه الرتبة تحرك إلى المعارف واشتاق إلى العلوم
وحدثت له قوى وملكات ومواهب من الله عز وجل يقتدر بها على الترقي والإمعان
في هذه الرتبة كما كان ذلك في المراتب الأخرى التي ذكرناها، وأول هذه
المراتب من الأفق الإنساني المتصل بآخر ذلك الأفق الحيواني مراتب الناس
الذين يسكنون في أقاصي المعمورة من الشمال والجنوب كأواخر الترك من بلاد
يأجوج ومأجوج وأواخر الزنج وأشباههم من الأمم التي لا تميز عن القرود إلا
بمرتبة يسيره. ثم تتزايد فيهم قوة التمييز والفهم إلى أن يصيروا إلى وسط
الأقاليم فيحدث فيهم الذكاء وسرعة الفهم والقبول للفضائل وإلى هذا الموضع
ينتهي فعل الطبيعة التي وكلها الله عز وجل بالمحسوسات.
ثم يستعد بهذا
القبول لإكتساب الفضائل واقتنائها بالإرادة والسعي والإجتهاد الذي ذكرناه
فيما تقدم حتى يصل إلى آخر أفقه فإذا صار إلى آخر افقه اتصل بأول أفق
الملائكة وهذا أعلى مرتبة الإنسان وعندها تتأحد الموجودات ويتصل أولها
بآخرها. وهو الذي يسمى دائرة الوجود لأن الدائرة هي التي قيل في حدها إنها
خط واحد يبتدىء بالحركة من نقطة وينتهي إليها بعينها ودائرة الوجود هي
المتأحدة التي جعلت الكثرة وحدة. وهي التي تدل دلالة صادقة برهانية على
موجدها وحكمته وقدرته ووجوده تبارك اسمه وتعالى جده وتقدس ذكره. ولولا أن
شرح هذا الموضوع لا يليق بصناعة تهذيب الأخلاق لشرحته وأنت تقف عليه إن
بلغت هذه الرتبة بمشيئة الله.
وإذا تصورت قدر ما أومأنا إليه وفهمته
اطلعت على الآلة التي خلقت وندبت إليها وعرفت الأفق الذي يتصل بأفقك
وتنقلك في مرتبة بعد مرتبة وركوبك طبقا عن طبق وحدث لك الإيمان الصحيح
وشهدت ما غاب عن غيرك من الدهماء وبلغت أن تتدرج إلى العلوم الشريفة
المكونة التي مبدؤها تعلم المنطق فإنه الآلة في تقويم الفهم والعقل
الغريزي. ثم الوصول به إلىمعرفة الخلائق وطباعها ثم التعلق بها والتوسع
فيها والتوصل منها إلى العلوم الإلهية وحينئذ تستعد لقبول مواهب الله
عزوجل وعطاياه فيأتيك الفيض الإلهي فتسكن عن قلق الطبيعة وحركاتها نحو
الشهوات الحيوانية وتلحظ المرتبة التي ترقيت فيها أولا فأولا من مراتب
الموجودات. وعلمت ان كل مرتبة منها محتاجة إلى قبلها في وجودها وعلمت أن
الإنسان لا يتم له كماله إلا بعد أن يحصل له ما قبله وإذا صار إنسانا
كاملا وبلغ غاية أفقه أشرق نور الأفق الأعلى عليه وصار إما حكيما تاما
تأتيه الإلهامات فيما يتصرف فيه من المحاولات الحكمية والتأييدات العلوية
في التصويرات العقلية وإما نبيا مؤيدا يأتيه الوحي على ضروب المنازل التي
تكون له عند الله تعالى ذكره. فيكون حينئذ واسطة بين الملأ الأعلى والملأ
الأسفل. وذلك بتصوره حال الموجودات كلها والحال التي ينتقل إليها من حال
الإنسية ومطالعة الآفاق التي ذكرناها. وحينئذ يفهم عن الله عزوجل قوله
(فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين) وتصور معنى قوله صلى الله عليه
وسلم (هناك مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) وإذا بلغ
الكلام إلى ذكر هذه المنزلة العالية الشريفة التي أهل الإنسان لها ونسقنا
أحواله التي يترقى فيها وأنه يكون أولا بالشوق إلى المعارف والعلوم فينبغي
أن نزيد في بيانه وشرحه فنقول:
الشوق إلى المعارف والعلوم
إن هذا الشوق ربما ساق الإنسان علىمنهج قويم وقصد صحيح حتى ينتهي إلى غاية كماله وهي سعادته التامة. وقلما يتفق ذلك وربما اعوج به عن السمت والسنن وذلك لأسباب كثيرة يطول ذكرها ولا حاجة بك إلى علمها الآن وأنت في تهذيب خلقك. فكما أن الطبيعة المدبرة للأجسام ربما شوقت إلى ما ليس بتمام للجسم الطبيعي لعلل تحدث به وآفات تطرأ عليه بمنزلة من يشتاق إلى أكل الطين وما جرى مجراه مما لا يكمل طبيعة الجسد بل يهدمه ويفسده. كذلك أيضا النفس الناطقة ربما اشتاقت إلى النظر والتمييز الذي لا يكملها ولا يشوقها نحو سعادتها بل يحركها إلى الأشياء التي تعوقها وتقصر بها عن كمالها فيحينئذ يحتاج إلى علاج نفساني روحاني كما احتاج في الحالة الأولى إلى طب طبيعي جسماني. ولذلك تكثر حاجات الناس إلى المقومين والمنفعين وإلى المؤدبين والمسددين. فإن وجود تلك الطبائع الفائقة التي تنساق بذاتها منغير توفق إلى السعادة عسرة الوجود ولا توجد إلا في الأزمنة الطوال والمدد البعيدة. وهذا الأدب الحق الذي يؤدينا إلى غايتنا يجب أن تلحظ فيه المبأ الذي يجري مجرى الغاية حتى إذا لحظت الغاية تدرج منها إلى الأمور الطبيعية على طريق التحليل ثم يبتدىء من أسفل على طريق التركيب فيسلك فيها إلى أن ينتهي إلى الغاية التي لحظت أولا. وهذا المعنى هو الذي أحوجنا في مبدأ هذا الكتاب وفي فصول أخر منه أن نذكر أشياء عالية لا تليق بهذه الصناعة ليتشوق إليها من يستحقها. وليس يمكن الإنسان أن يشتاق إلى ما لا يعرفه ألبتة. فإذا لحظها من فيه قبول لها وعناية بها عرفها بعض المعرفة فتشوقها وسعى نحوها واحتمل التعب والنصب فيها. وينبغي أن يعلم أن كل إنسان معد نحو فضيلة ما فهو إليها أقرب وبالوصول إليها أحرى. ولذلك لا تصير سعادة الواحد من الناس غير سعادة الآخر غلا من اتفق له نفس صافية وطيعية فائقة فينتهي إلى غايات الأمور وعلى غاياتها أعني السعادة القصوى التي لا سعادة بعدها.الواجب على الحاكمولأجل ذلك يجب على مدير المدن أن يسوق كل إنسان نحو سعادته التي تخصه ثم يقسم عنايته بالناس ونظره لهم بقسمين: أحدهما في تسديد الناس وتقويمهم بالعلوم الفكرية. والأخر في تسديدهم نحو الصناعات والأعمال الحسية. وإذا سددهم نحو السعادة الفكرية بدأبهم من الغاية الأخيرة على طريق التحليل ووقف يهم عند القوي التي ذكرناها. وإذا سددهم نحو السعادة العملية بدأبهم من عند هذه القوي وانتهى بهم إلى تلك الغاية. ولما كان غرضنا في هذا الكتاب السعادة الخلقي وأن تصدر عنا الأفعال كلها جميلة كما رسمنا في صدر الكتاب وعملناه لمحبي الفلسفة خاصة لا للعوام وكان النظر يتقدم العمل.
وجب أن نذكر الخير المطلق والسعادة الإنسانية لتلحظ الغاية الأخيرة ثم تطلب بالأفعال الإرادية التي ذكرنا جملها في المقالة الأولى. وأرسطوطاليس إنما بدأ كتابه بهذا الموضع وافتتحه بذكر الخير المطلق ليعرف ويتشوق.
ونحن نذكر ما قاله ونتبعه بما أخذناه أيضا عنه في مواضع أخر ليجتمع ما فرقه ونضيف إلى ذلك ما أخذناه عن مفسري المنقلبين لحكمته نحو استطاعتنا، والله الموفق المؤيد فإن الخير بيده وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نبدأ بمعونة الله تعالى
في هذه المقالة بذكر الفرق بين الخير والسعادة بعد أن نذكر ألفاظ أرسطوطا
ليس إقتداء به وتوفية لحقه فنقول: إن الخير على ما حده واستحسنه من آراء
المتقدمين هو المقصود من الكل وهو الغاية الأخيرة. وقد يسمى الشيء النافع
في هذه الغاية خيرا. فأما السعادة فهي الخير بالإضافة إلى صاحبها وهي كمال
له. فالسعادة إذا خير ما وقد تكون سعادة الإنسان غير سعادة الفرس وسعادة
كل شيء في تمامه وكماله الذي يخصه. فأما الخير الذي يقصده الكل بالشوق فهو
طبيعة تقصد ولها ذات وهو الخير العام للناس من حيث هم ناس فهم بأجمعهم
مشتركون فيها. فأما السعادة فهي خير مالواحد واحد من الناس فهي إذا
بالإضافة ليست لها ذات معينة وهي تختلف بالإضافة إلى قاصديها. فلذلك يكون
الخير المطلق غير مختلف فيه. وقد يظن بالسعادة أنها تكون لغير الناطقين.
فإن كان ذلك فإنما هي استعدادات فيها لقبول تماماتها وكمالاتها من غير قصد
ولا رويى ولا إرادة وتلك الإستعدادات هي الشوق أو ما يجري مجرى الشوق من
الناطقين بالإرادة. فأما ما يتأتى للحيوانات في مآكلها ومشاربها وراحاتها
فينبغي أن نسمى بختا أواتفاقا ولا يؤهل لإسم السعادة كما يسمى في الإنسان
أيضا. وإنما استحسن الحد الذي ذكرنا للخير المطلق لأن العقل لا يطلق السعي
والحركة إلا إلى نهاية وهذا أول في العقل. ومثال ذلك أن الصناعات والهمم
والتدابير الإختيارية كلها يقصد بها خير ما وما لم يقصد به خير ما فهو عبث
والعقل يحظره ويمنع منه وبالواجب صار الخير المطلق هو المقصود إليه من كل
الناس. ولكن بقى أن يعلم ما هو وما الغاية الأخيرة منه التي هي غاية
الخيرات التي ترتقي الخيرات كلها إليها حتى نجعله غرضنا وتوجه إليه ولا
نلتفت إلى غيره ولا تنتشر أفكارنا في الخيرات الكثيرة التي تؤدي إليه إما
تأدية بعيدة وإما تأدية قريبة ولا نغلط أيضا فيما ليس بخير فنظنه خيرا ثم
نفي أعمارنا في طلبه والتعب به وكلا سنبينه بمشيئة الله وعونه.
أقسام الخير
الخير على قسمه أرسطوطا ليس وحكاه عنه قرقوريوس غيره قال الخيرات منها ما هي شريفة ومنها ماهي ممدوحة ومنها ما هي بالقوى كذلك وما هي نافعة فيها. فالشريفة منها هي التي شرفها من ذاتها وتجعل من اقتناها شريفا وهي الحكمة والعقل والممدوحة منها مثل الفضائل والأفعال الجميلة الإرداية والتي هي بالقوى مثل التهيء والإستعداد لنيل الأشياء التي تقدمت والنافعة هي جميع الأشياء التي تطلب لا لذاتها بل ليتوصل بها إلى الخيرات (وعلى جهة أخرى) الخيرات منها ما هي غايات ومنها ما ليست بغايات والغايات منها ما هي تامة ومنها ما هي غير تامة. فالتي هي تامة كالسعادة. وذلك أنا إذا وصلنا إليها لم نحتج أن نستزيد فنقتني أشياء أخر. وأما التي ليست بغاية ألبتة فكالعلاج والتعلم والرياضة (وعلى جهة أخرى) الخيرات منهاما هو مؤثر لأجل ذاته ومنها ما هو مؤثر لأجل غيره ومنها ما هو مؤثر للأمرين جميعا ومنها ما هو خارجعنها (وعلى جهة أخرى) الخيرات منها ما هوخير على الإطلاق ومنها ما هو خير عند الضرورة والإتفاقات التي تتفق لبعض النسا وفي وقت دون وقت. وأيضا منها ما هو خير لجميع الناس ومن جميع الوجوه وفي جميع الأوقات ومنها ما ليس بخير لجميع الناس ولا ما هو في المية ومنها ما هو في الكيفية وفي سائر المقولات كالقوى والملكات.ومنها كالأحوال ومنها كالأفعال ومنها كالغايات ومنها كالمواد ومنها كالآلات ووجود الخيرات في المقولات كلها يكون على هذا المثال.
أما في الجوهر أعني ماليس بعرض فالله تبارك وتعالى هو الخير الأول فإن جميع الأشياء تتحرك نحوه بالشوق إليه ولأن مآل الخيرات الإلهية من البقاء والسرمدية والتمام منه.
وأما في الكمية فالعدد فالمعتدل والمقدار المعتدل وأما في الكيفية فكاللذات، وأما في الإضافة فالكالصدقات والرياسات وأما في الأين والمتة فكالمكان المعتدل والزمان الأنيق البهج. وأما في الموضع فكالقعود والإضطجاع والإتكاء الموافق. وأما في الملك فكالأموال والمنافع وأما في الإنفعال فكالسماع الطيب وسائر المحسوسات المؤثرة وأما في الفعل فكنفاذ الأمر ورواج الفعل (وعلى جهة أخرى) الخيرات منها معقولات ومنها محسوسات.
وأما السعادة فقد قلنا أنها خير ما وهي تمام الخيرات
وغاياتها والتمام هو الذي إذا بلغنا إليه لم نحتج معه إلى شيء آخر فلذلك
نقول: أن السعادة هي أفضل الخيرات ولكنا نحتاج في هذا التمام الذي هو
الغاية القصوى إلى سعادات أخرىوهي التي في البدن والتي خارج البدن (وارسطو
طاليس) يقول أنه يعسر على الإنسان أن يفعل الأفعال الشريفة بلا مادة مثل
اتساع اليد وكثرة الأصدقاء وجودة البخت. قال ولهذا ما احتاجت الحكمة إلى
صناعة الملك في إظهار شرفها. قال ولهذا قلنا إن كان شيء عطية من الله
تعالى وموهبة للناس فهو السعادة لأنها عطية منه عز إسمه وموهبة في أشرف
منازل الخيرات وفي أعلى مراتبها وهوخاصة بالإنسان التام ولذلك لا يشاركه
فيها من ليس بتام كالصبيان ومن يجري مجراهم. وأما أقسام السعادى على مذهب
هذا الحكيم فهي خمسة أقسام. أحدها في صحة البدن ولطف الحواس ويكون ذلك من
اعتدال المزاج أعني أن يكون جيد السمع والبصر والشم والذوق واللمسز
والثاني في الثروة والأعوان وأشباهما حتى يتسع لأن يضع المال في موضعه
ويعمل به سائر الخيرات ويواسي منه أهلالخيرات خاصة والمستحقين عامة ويعمل
به كل ما يزيد في فضائله ويستحق الثناء والمدح عليه. والثالث أن تحسن
أحدوثته في الناس وينشر ذكره بين أهل الفضل فيكون ممدوحا بينهم ويكثرون
الثناء عليه لما يتصرف فيه من الإحسان والمعرفة. والرابع أن يكون منجحا في
الأمور وذلك إذا استتم كل ما روى فيه وعزم عليه حتى يصير إلى ما يأمله
منه. والخامس أن يكون جيد الرأى صحيح الفكر سليم الإعتقادات في دينه وغير
دينه بريئا من الخطأ والزلل جيد المشورة في الآراء.
فمن اجتمعت له هذه
الأقسام كلها فهو السعيد الكامل على مذهب هذا الرجل الفاضل ومن حصل له
بعضها كان حظه من السعادة بحسب ذلك. وأما الحكماء قبل هذا الرجل مثل
فيثاغورس وبقراط وأفلاطون وأشباههم فإنهم أجمعوا على أن الفضائل والسعادة
كلها في النفس وحدها. ولذلك لما قسموا السعادة جعلوها كلها في قوى النفس
التي ذكرناها في أول الكتاب (وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة)
وأجمعوا على أن هذه الفضائل هي كافية في السعادة ولا يحتاج معها إلى غيرها
من فضائل البدن ولا ما هو خارج البدن، فإن الإنسان إذا حصل تلك الفضائل لم
يضره في سعادته أن يكون سقيما ناقص الأعضاء مبتلي بجميع أمراض البدن.
اللهم إلا أن يلحق النفس منها مضرة في خاص أفعالها مثل فساد العقل ورداءة
الذهن وما أشبهها. وأما الفقر والخمول وسقوط الحال وسائر الأشياء الخارجة
عنها فليست عندهم بقادحة في السعادة ألبتة، وأما الرواقيون وجماعة من
الطبيعيين فإنهم جعلوا البدن جزءا من الإنسان ولم يجعلوه آلة كما شرحناه
فيما نقدم. فلذلك اضطروا إلى أن يجعلوا السعادة التي في النفس غير كاملة
إذا لم يقترن بها سعادة البدن وما هو خارج البدن أيضا أعني الأشياء التي
تكون بالبخت والجد، والمحققون من الفلاسفة يحقرون أمر البخت وكل ما يكون
به ومعه ولا يؤهلون تلك الأشياء لإسم السعادة لأن السعادة شيء ثابت زائل
ولا متغير وهي أشرف الأمور وأكرمها وأرفعها فلا يجعلون لأحسن الأشياء وهو
الذي يتغير ولا يثبت ولا يتحصل بروية ولا فكر ولا يتأتى بعقل وفضيلة فيها
نصيبا.
ولهذا النظر اختلف القدماء في السعادة العظمى فظن قوم أنها
لا تحصل للإنسان إلا بعد مفارقة البدن والطبيعات كلها وهؤلاء هم القوم
الذين حكينا عنهم أن السعادة العظمى هي في النفس وحدها وسموا الإنسان ذلك
الجوهر وحده دون البدن ولذلك حكموا أنها ما دامت في البدن ومتصلة بالطبيعة
وكدرها ونجاسات البدن وضروراته وحاجت الإنسان به وافتقاراته إلى الأشياء
الكثيرة فليست سعيدة على الإطلاق. وأيضا لما روأها لا تكمل لوجود الأشياء
العقلية لأنها لا تستتر عنها بظلمة الهيولي أعني قصورها ونقصانها ظنوا
أنها إذا فارقت هذه الكدورة فارقت الجهالات وصفت وخلصت وقبلت الإضاءة
والنور الإلهي أعني العقل التام. ويجب على رأى هؤلاء أن الإنسان لا يسعد
السعادة التامة إلا في الآخرة بعد موته، وأما الفرقة الأخرى فإنها قالت
انه من القبيح الشنيع أن يظن أن الإنسان ما دام حيا يعمل الأعمال الصالحة
ويعتقد الآراء الصحيحة ويسعى في تحصيل الفضائل كلها لنفسه أولا ثم لأبناء
جنسه ثانيا ويخلف رب العزة تقدس ذكره في خلقه بهذه الأفعال المرضية فهو
شقي ناقص حتى إذا مات ودم ذكر الأشياء صار سعيدا تام السعادة.
وارسطوطاليس
يتحقق بهذا الرأى وذلك أنه تكلم في السعادة الإنسانية والإنسان هو المركب
عنده من بدن ونفس ولذلك حد الإنسان بالناطق المائت وبالناطق الماشي برجلين
وما أشبه ذلك وهذه الفرقة التي رئيسها أرسطوطاليس رأت ان السعادة
الإنسانية تحصل لللإنسان في الدنيا إذا سعى لها وتعب بها حتى يصير إلى
أقصاها ولما رأى الحكيم ذلك وأن الناس مختلفون في هذه السعادة الإنسانيةن
وأنها قد أشكلت عليهم أشكالا شديدا احتاج أن يتعب في الإبانة عنها وإطالة
الكلام فيها. وذلك أن الفقير يرى أن السعادة العظمى في الثروة واليسار.
والمريض يرى أنها في الصحة والسلامة. والذليل يرى أنها فيالجاه والسلطان.
والخليع يرى أنها في التمكن من الشهوات كلها على اختلافها والعاشق يرى
أنها في الظفر بالمعشوق. والفاضل يرى أنها في إفاضة المعروف على
المستحقين. والفيلسوف يرى أن هذه كلها إذا كانت مرتبة بحسب تقسيط العدل
أعني عند الحاجة وفي الوقت الذي يجب وكما يجب وعند من يجب. فهي سعادات
كلها وما كان منها يراد لشيء آخر فذلك الشيء أحق باسم السعادة ولما كانت
كل واحدة من هاتين الفرقتين نظرت نظرا ما وجب أن نقول في ذلك ما نراه
صوابا وجامعا للرأيين فنقول:
رأى المؤلف في السعادة
إن الإنسان ذو فضيلة روحانية يناسب بها الأرواح الطيبة التي تسمى ملائكة وذو فضيلة جسمانية يناسب بها الأنعام لأنه مركب منهما فهو بالخير الجسماني الذي يناسب به الأنعام مقيم في هذا العالم السفلي مدة قصيرة ليعمره وينظمه ويرتبه. حتى إذا ظفر بهذه المرتبة على الكمال انتقل إلى العالم العلوي وأقام فيه دائما سرمدا في صحبة الملائكة والأرواح الطيبة وينبغي أن يفهم من قولنا العالم السفلي والعالم االعلوي ما ذكرناه فيما تقدم. فإنا قد قلنا هناك أنا لسنا نعني بالعلوي المكان العلى في الحس ولا بالعالم السفلي المكان الأسفل في الحس بل كل محسوس فهو أسفل وإنكان محسوسا في المكان الأعلى. وكل معقول فيهو أعلى وإن كان معقولا في المكان الأسفل وينبغي أن يعلم أنه لا يحتاج في صحة الأرواح الطيبة المستغنية عن الأبدان إلى شيء من السعادات البدنية التي ذكرناها سوى سعادة النفس فقط أعني المعقولات الأبدية التي هي الحكمة فقط. فإذا ما دام الإنسان إنسانا فلا تتم له السعادة إلا بتحصيل الحالين جميعا وليس يحصلان على التمام إلا بالأشياء النافعة في الوصول إلى الحكمة الأبدية. فالسعيد إذا من الناس يكون في إحدى مرتبتين. إما في مرتبة الأشياء الجسمانية متعلقا بأحوالها السفلى سعيدا بها وهو مع ذلك يطالع الأمور الشريفة باحثا عنها مشتقا إليها متحركا نحوها مغتبطا بها. وإما أن يكون في رتبة الأشياء الروحانية متعلقا بأحوالها العليا سعيدا بها وهو مع ذلك يطالع الأمور البدنية معتبرا بها ناظرا في علامات القدرة الإلهية ودلالل الحكمة البالغة مقتديا بها ناظما لها مفيضا للخيرات عليها سابقا لها نحو الأفضل، فالأفضل بحسب قبولها وعلى نحو استطاعتها. وأي امرىء لم يحصل في إحدى هاتين المنزلتين فهو في رتبة الأنعام بل هو أضل. وإنما صار أضل لأن تلك غير معرضة لهذه الخيرات ولا أعطيت استطاعة تتحرك بها نحو هذه المراتب العالية. وإنما تتحرك بقواها نحو كمالاتها الخاصة بها والإنسان معرض لها مندوب إليها مزاح العلة فيها وهو مع ذلك غير محصل لها ولا سع نحوها.
وهو مع ذلك مؤثر لضدها يستعمل
قواه الشريفة في الأمور الدنيئة وتلك محصلة لكمالاتها التي تخصها فإذا
الأنعام إذا منعت الخيرات الإنسية حرمت جوار الأرواح الطيبة ودخول الجنة
التي وعد المتقون فهي معذورة. والإنسان غير معذور. مثل الأول مثل الأعمى
إذا جار عنالطريق فتردى في بئر فهو مرحوم غير ملوم. ومثل الثاني مثل بصير
يجور على بصيرة حتى يتردى في البئر فهو ممقوت ملوم. وإذ قد تبين أن السعيد
لا محالة في إحدى المرتبتين اللتين ذكرناها فقد تبين أيضا أن أحدهما ناقص
مقصر عن الآخر وأن الأنقص منهما ليس يخلو ولا يتعرى من الآلام والحسرات
لأجل خدائع الطبيعة والزخارف الحسية التي تعترضه فيما يلابسه وتعوقه عما
يلاحظه وتمنعه من الترقي فيها على ما ينبغي وتشغله بما يتعلق به من الأمور
الجسمانية. فصاحب هذه المرتبة غير كامل على الإطلاق ولا سعيد تام، وأن
صاحب المرتبة الأخرى هو السعيد التام وهو الذي توفر حظه من الحكمة فهو
مقيم بروحانيته بين الملاء الأعلى يستمد منهم لطائف الحكمة ويستنير بالنور
الإلهي ويستزيد من فضائله بحسب عنايته بها وقلة عوائقه عنها. ولذلك يكون
أبدا خاليا من الآلام والحسرات التي لا يخلو صاحب المرتبة الأولى منها
ويكون مسرورا أبدا بذاته مغتبطا بحاله وبما يحصل له دائما من فيض نور
الأمل فليس يسر إلا بتلك الأحوال ولا يغتبط إلا بتلك المحاسن ولا يهش إلا
لإظهار تلك الحكمة بين أهلها ولا يرتاح إلا لمن ناسبه أو قاربه وأحب
الإقتباس منه. وهذه المرتبة التي من وصل إليها فقد وصل إلى آخر السعادات
وأقصاها وهو الذي لا يبالي بفراق الأحباب من أهل الدنيا ولا يتحسر على ما
يفوته من التنعم فيها. وهو الذي يرى جسمه وماله وجميع خيرات الدنيا التي
عددناها في السعادات التي في بدنه الخارجة عنه كلها كلا عليه إلا في
ضرورات يحتاج إليها لبدنه الذي هو مربوط به لا يستطيع الإنحلال عنه إلا
عند مشيئة خالقه وهو الذي يتشاق إلى صحبة أشكاله وملاقاة من يناسبه من
الأرواح الطيبة والملائكة المقربين. وهو الذي لا يفعل إلا ما أراده الله
منه ولا يختار إلا ما قرب إليه لا يخالفه إلى شيء من شهواته الرديئة ولا
ينخدع بخدائع الطبيعة ولا يلتفت إلى شيء يعوقه عن سعادته.
وهو الذي لا
يحزن على فقد محبوب ولا يتحسر على فوت مطلوب. إلا أن هذه المرتبة الأخيرة
تتفاوت تفاوتا عظيما أعني أن من يسل إليها من الناس يكون على طبقات كثيرة
غير متقاربة.
وهاتان المرتبتان هما اللتان ساق الحكيم الكلام إليهما
واختار المرتبة الأخيرة منهما وذلك في كتابه المسمى " فضائل النفس " وأنا
أورد ألفاظه التي نقلت إلى العربية بعينها قال: ؟؟أول رتب الفضائل اول رتب
الفضائل تسمى سعادة وهي أن يصرف الإنسان إرادته ومحاولاته إلى مصالحه في
العالم المحسوس والأمور المحسوسة من أمور النفس والبدن وما كان من الأحوال
متصلا بهما ومشاركا لهما من الأمور النفسانية ويكون تصرفه في الأحوال
المحسوسة تصرفا لا يخرج به عن الإعتدال الملائم لأحواله الحسية. وهذه حال
قد يتلبس فيها الإنسان بالأهواء والشهوات إلا ان ذلك بقدر معتدل غير مفرط
وهو إلى ما ينبغي أقرب منه إلى ما لا يسيغه وذلك انه يجري أمره نحو صواب
التدبير المتوسط في كل فضيلة ولا يخرج به عن تقدير الفكر وأن لابس الأمور
المحسوسة وتصرف فيها.
ثم الرتبة الثانية وهي التي يصرف الإنسان فيها
إرادته ومحاولاته إلى الأمر الأفضل من صلاح النفس والبدن من غير أن يتلبس
مع ذلك بشيء من الأهواء والشهوات ولا يكترث بشيء من النفسيات المحسوسة إلا
بما تدعوه إليه الضرورة. ثم تتزايد رتبة الإنسان في هذا الضرب من الفضيلة.
وذلك أن الأماكن والرتب في هذا الضرب من الفضائل كثيرة بعضها فوق بعض وسبب
ذلك. اما أولا فاختلاف طبائع الناس. وثانيا على حسب العادات.
وثالثا
بحسب منازلهم ومواضعهم من الفضل والعلم والمعرفة والفهم. ورابعا بحسب
همهم. وخامسا بحسب شوقهم ومعاناتهم ويقال ايضا بحسب جدهم.
ثم تكون
النقلة في آخر هذه المرتبة أعني هذا الصنف من الفضيلة إلى الفضيلة الإلهية
المحضة. وهي التي لا يكون فيها تشوف إلى آت ولا تلفت إلى ماض ولا تشييع
لحال ولا تطلع إلى ناء ولا ضن بقريب ولا خوف ولا فزع من أمر ولا شغف بحال
ولا طلب لحظ من حظوظ الإنسانية ولا من الحظوظ النفسانية أيضا ولا ما تدعو
الضرورة إليه من حاجة البدن والقوى الطبيعية ولا القوى النفسانية. لكن
يتصرف بتصرف الخير العقلي في أعالي رتب الفضائل وهو صرف الوكد إلى الأمور
الإلهية ومعاناتها ومحاولاتها بلا طلب عوض أعني أن يكون تصرفه فيها
ومعاناته ومحاولته لها لنفس ذاتها فقط وهذه الرتبة أيضا تتزايد بالناس
بحسب الهمم والشوق وفضل المعاناة والمحاولة وقوة التحيزة؟ وصحة القة وحسب
الهمم والشوق وفضل المعاناة والمحاولة وقوة التحيزة؟ وصحة الثقة وبحسب
منزلة من بلغ إلى هذا المبلغ من الفضيلة في هذه الأحوال التي عددناها إلى
أن يكون تشبهه بالعلة الأولى واقتداؤه بها وبأفعالها.
آخر مراتب الفضائل
وآخر المراتب في الفضيلة أن تكون أفعال الإنسان كلها أفعال الهية وهذه الأفعال هي خير محض والفعل إذا كان خيرا محضا فليس يفعله فاعله من أجل شيء آخر غير الفعل نفسه. وذلك أن الخير المحض هو غاية متوخاة لذاتها أي هو الأمر المطلوب المقصود لذاته. والأمر الذي هو غاية متوخاة لذاتها أي هو الأمر المطلوب المقصود لذاته. والأمر الذي هو غاية في نهاية النفاسة ليس يكون من أجل شيء آخر. فأفعال الإنسان إذا صارت كلها إلاهية فهي كلها إنما تصدر عن لبه وذاته الحقيقية التي هي عقله الإلهي الذي هو ذاته بالحقيقة وتزول وتتهدر سائر دواعي طباعه البدني بسائر عوارض النفسين البهيميتين وعوارض التخيل المتولد عنهما وعن دواعي نفسه الحسية فلا يبقى له حينئذ ارادة ولا همة خارجتان عن فعله من أجلهما يفعل مايفعل. لكنه يفعل ما يفعله بلا إرادة ولا همة في سوي الفعل أي لا يكون غرضه في فعله غير ذات الفعل وهذا هو سبيل العقل الإلهي. فهذه الحال هي آخر رتب الفضائل التي يتقبل فيها الإنسان أفعال المبدأ الأول خالق الكل عز وجل.أعني أن يكون فيما يفعله لا يطلب به حظا ولا مجازاة ولا عوضا ولا زيادة لكن يكون فعله بعينه هو غرضه أي ليس يفعل من أجل شيء آخر سوى ذات الفعل. ومعنى ذاته هو أن لا يفعل ما يفعله من أجل شيء غير فعله نفسه وذاته نفسها هي الفعل الإلهي نفسه وهكذا يفعل الباري تعالى لذاته لا من أجل شيء آخر خارج عنه. وذلك أن فعل الإنسان في هذه الحال يكون كما قلنا خيرا محضا وحكمة محضة فيبدأ بالفعل لنفس إظهار الفعل فقط لا لغاية أخرى يتوخاها بالفعل وهكذا فعل الله عز وجل الخاص به ليس هو على القصد الأول من أجل شيء خارج عن ذاته. أعني ليس ذلك من أجل سياسة الأشياء التي نحن بعضها لأنه لو كان كذلك لكانت أفعاله حينئذ من أجل سياسة الشياء التي نحن بعضها لأنه لو كان كذلك لكانت أفعاله حينئذ إنما كانت وتكون وتتم بمشارفة الأمور التي من خارج ولتدبيرها وتدبير أحوالها وإهتمامه بها.
وعلى هذا تكون الأشياء التي من خارج أسبابا وعللا لأفعاله. وهذا شنيع قبيح تعالى الله عنه علوا كبيرا. لكن عنايته عزوجل بالأشياء التي من خارج وفعله الذي يدبرها به ويرفدها إنما هو على القصد الثاني وليس يفعل ما يفعله من أجل الأشياء أنفسها لكن من أجل ذاته أيضا. وذلك لأجل أن ذاته تفضل لذاتها لا من أجل المفضل عليه ولا من أجل شيء آخر. وهكذا سبيل الإنسان إذا بلغ إلى الغاية القصوى في الإمكان من الإقتداء بالباري عز وجل وتكون أفعاله التي يفعلها على القصد الأول من أجل ذلك الغير لكن يفعل بذلك الغير ما يفعله به بقصد ثان وفعله ذلك من أجل ذاته بالقصد الأول ومن اجل الفعل نفسه أي لنفس الفضيلة ولنفس الخير لأن فعله ذلك فضيلة وخير ففعله لنفس الفعل لا لإجتلاب منفعة ولا لدفع مضرة ولا للتباهي وطلب الرياسة ومحبة الكرامة فهذا هو غرض الفلسفة ومنهى السعادة. إلا أن الإنسان لا يصل إلى هذه الحال حتى تفني إرادته كلها التي بحسب الأمور الخارجة وتفني العوارض النفسانية وتموت خواطره التي تكون عن العوارض ويمتلىء شعارا إلهيا وهمة إلهية.
وإنما يمتلأ من ذلك إذا صفا من
الأمر الطبيعي ألبتة ونفى منه نفيا كاملا. ثم حينئذ يمتلىء معرفة إلهية
وشوقا إلهيا ويوقن بالأمور الإلهية بما يتقرر في نفسه وفي ذاته التي هي
العقل كما تقررت فيه القضايا الأول التي تسمى العلوم الأوائل. إلا أن تصور
العقل ورويته في هذه الحال بالأمور الإلهية وتيقنه لها يكون بمعنى أشرف
وألطف وأظهر وأشهد انكشافا له وبيانا من القضايا الأول التي تسمىالعلوم
الأوائل العقلية. فهذه ألفاظ هذا الحكيم قد نقلتها نقلا. (وهي نقل أبي
عثمان الدمشقي. وهذا الرجل فصيح باللغتين جميعا أعني اليونانية والعربية
مرضى النقل عند جميع من طالع هاتين اللغتين وهو مع ذلك شديد التحري لا
يراد الألفاظ اليونانية ومعانيها من ألفاظ العرب ومعانيها لا تختلف في لفظ
ولامعنى، ومن رجع إلى هذا الكتاب أعني المسمى بفضائل النفس قرأ هذه
الألفاظ كما نقلتها) وليست تحصل هذه المراتب التي يترقى فيها صاحب السعادة
التامة إلا بعد أن يعلم أجزاء الحكمة كلها علما صحيحا ويستوفيها أولا أولا
كما رتبناها في كتابنا المسمى بترتيب السعادات. ومن ظن من الناس أنه يصل
إليها بغير تلك الطريقة وعلى غير ذلك المنهج فقد ظن باطلا وبعد عن الحق
بعدا كثيرا. وليتذكر في هذا الموضع الخطأ العظيم الذي وقع فيه قوم ظنوا
أنهم يدركون الفضيلة بتعطيل القوة العالمة وإهمالها وبترك النظر الخاص
بالعقل واكتفائهم بأعمال ليست مدنية ولا بحسب ما يقسطه التمييز والعقل.
وقد
سماهم قوم العاملة والناجية. ولذلك رتبنا هذا الكتاب عقب ذلك الكتاب ليلحظ
منهما السعادة الأخيرة المطلوبة بالحكمة البالغة وتتهذب لها النفس وتتهيأ
لقبولها غسلا وتنقية من الأمور الطبيعية وشهوات الأبدان. ولذلك سميته أيضا
بكتاب طهارة الأعراق (وقد قال أرسطوطاليس في كتابه المسمى بالأخلاق) إن
هذا الكتاب لا ينتفع به الأحداث كثير منفعة ولا من هو في طبيعة الأحداث
قال ولست أعني بالحدث ههنا حدث السن لأن الزمان لا تأثير له في هذا
المعنى. وإنما أعني السيرة التي يقصدها أهل الشهوات واللذات الحسية. وأما
أنا فأقول أني ما ذكرت هذه المرتبة الأخيرة من السعادة طمعا في وصول
الأحداث إليها. بل ليمر على سمعهم فقط وليعلم أن ههنا مرتبة حكمية لا يصل
إليها إلا أهلها الأعلون مرتبة. فليلتمس كل من نظر في هذا الكتاب المرتبة
الأولى منها بالأخلاق التي وصفتها فإن وفق بعد ذلك وأعانه الشوق الشديد
والحرص التام وسائر ما ذكرناه ووصفناه عن الحكيم فليترق في درجة الحكمة
وليتصاعد فيها بجهده فإن الله عز وجل يعينه ويفقه. فإذا بلغ الإنسان إلى
غاية هذه السعادة ثم فارق بجسمه الكثيف دنياه الدنيئة وتجرد بنفسه اللطيفة
التي عنى بتطهيرها وغسلها من الأدناس الطبيعية لأخراه العلية فقد فاز وأعد
ذاته للقيا خالقه عزوجل أعدادا روحانيا لبس فيه نزاع إلى تلك القوى التي
كانت تعوقه عن سعادته ولاتشوق إليها لأنه قد تطهر منها وتنزه عنها ولم تبق
فيه إرادة لها ولا حرص عليها وقد استخلصها للقاء رب العالمين ولقبول
كراماته وفيض نوره الذي كان غير مستعد له ولا فيه قبول من عطائه ويأتيه
حينئذ الذي وعد به المتقون والأبرار كما سبق الإيماء إليه مرارا في قوله
عزوجل (فَلا تَعلَمُ نَفسٌ ما أُخفيَ لَهُم مِن قُرَةِ أَعيُن): وفي قول
النبي صلى الله عليه وسلم: {هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على
قلب بشر}.
الرتبة الأولى من السعادة الأخيرة
وإذ قد لخصنا أمر هاتين المنزلتين من السعادة القصوى فقد تبين بيانا كافيا أن إحداهما بالإضافة إلينا أولى والأخرى ثانية ومن المحال أن أنسلك إلى الثانية من غير أن نمر بالأولى فقد وجب أن نعود إلى ما بدأنا به من ذكر الرتبة الأولى من السعادة الأخيرة ونستوفي الكلام فيها وفي الأخلاق التي بنينا الكتاب عليها ونخلي عن بيان الرتبة الثانية إلى وقت آخر فنقول: أن من عنى ببعض القوى التي ذكرناها دون بعض أو تعمد لإصلاحها في وقت دون وقت لم تحصل له السعادة. وكذلك يكون حال الرجل في تدبير منزله إذا عنى ببعض أجزائه دون بعض أو في وقت دون وقت فإنه لا يكون مدبر منزل. وكذلك حال مدبر المدينة إذا خص بنظره طائفة دون طائفة أووقتا دون وقت لا يستحق إسم الرياسة على الإطلاق. (وارسطوطاليس: تمثل بأن قال أن الخطاف الواحد إذا ظهر لا يدل على طبيعة الربيع. ولا يوم واحد معتدل الهواء يبشر بالربيع. فعلى طالب السعادة أن يطلب السيرة اللذيذة عنده فيسر بها دائما فإن تلك السيرة هي واحدة ولذيذة في نفسها. فلذلك قلنا أنه ينبغي أن يتشوقها دائما ويثبت عليها أبدا، ولما كانت السيرة ثلاثة لأنها تنقسم بإنقسام الغايات الثلاثة التي يقصدها الناس. أعني سيرة اللذة وسيرة الكرامة. وسيرة الحكمة وكنت سيرة الحكمة أشرفها وأتمها وكانت فضائل النفس كثيرة. وجب أن يفضل الإنسان بأفضلها ويشرف بأشرفها. فسيرة الأفاضل السعداء سيرة لذيذة بنفسها لأن أفعالهم أبدا مختارة وممدوحة وكل إنسان يلتذ بما هو محبوب عنده. يلتذ بعدل العادل أو يلتذ بحكمة الحكيم والأفعال الفاضلة والغايات التي ينتهي إليها بالفضائل لذيذة محبوبة فالسعادة ألذ من كل شيء " وأرسطوطاليس يقول أن السعادة الإلهية وإن كانت كما ذكرناها من الشرف وسيرتها ألذ وأشرف من كل سيرة فإنها محتاجة إلى السعادات الأخر الخارجة لأن تظهر بها وإلا كانت كامنة غير ظاهرة. وإن كانت كذلك كان صاحبها كالفاضل النائم الذي لا يظهر فعله وحينئذ لا يكون بينه وبين غيره فرق ما وصفنا حالهما فيما تقدم فالمطلع إذا على حقيقة هذه السعادة المتمكن من إظهار فعله بها هو الذي يلتذ بها وهو الذي يسر سرورا حقيقيا غير مموه ولا مزخرف بالباطل. وهو الذي يخرج من حد المحبة إلى العشق والهيمان وحينئذ يأنف أن يصير سلطانه العالي يحب سلطان بطنه وفرجه فلا يخدم بأشرف جزء فيه أخس جزء فيه. وأعني بالسرور والمزخرف بالأباطيل اللذات التي تشاركنا فيها الحيوانات التي ليست بناطقة فإن تلك اللذات حسية تنصرم وشيكا وتملها الحواس سريعا. فإذا دامت عليها صارت كريهة وربما عادت مؤلمة وكما أن للحس لذة عرضية على حدة فكذلك للعقل لذة ذاتية على حدة لأن لذة العقل لذة ذاتية ولذة الحس عرضية. فمن لا يعرف اللذة بالحقيقة كيف يلتذ بها؟ ومن لا يعرف الرياسة الذاتية كيف يصير إليها؟ فأنا قد قدمنا وصفها وشوقنا إليها بإعادة الكلام فيها مرارا وقلنا. من لا يعرف الخير المطلق والفضيلة التامة ولا يعرف الحكمة العملية يعني إيثار الأفضل والعمل به والثبات عليه لا ينشط له ولا يرتاح إليه. ومن كان كذلك فكيف يلتذ ويتنعم بما شرحناه ودللنا عليه؟ وقد كان للحكماء المتقدمين مثل يضربونه ويكتبونه في الهياكل " وهي مساجدهم ومصلاهم: وهو هذا الملك الموكل بالدنيا يقول إن ههنا خيرا وهناك شرا وههنا ما ليس بخير ولا شر. فمن عرف هذه الثلاثة حق معرفتها تخلص مني ونجا سالما. ومن لم يعرفها قتلته شر قتلة وذلك أني لا أقتله قتلا وحيا ولكني أقتله أولا أولا في زمان طويل " .
فهذا المثل من نظر فيه وتأمله عرف منه جميع ما قدمنا ذكره،
وينبغي أن يعلم ان السعيد الذي ذكرنا حاله ما دام حيا تحت هذا الفلك
الدائر بكواكبه ودرجاته ومطالع سعوده ونحوسه يرد عليه من النكبات والنوائب
وأنواع المحن والمصائب ما يرد على غيره. إلا أنه يذعر منها ولا يلحقه ما
يلحق غيره من المشقة في احتمالها لأنه غير مستعد لسرعة الإنفصال منها
بعادة الهلع والجزع والأحزان ولا قابل أثر الهموم والأحزان بالأحوال
العارضة. وإن أصابه من هذه الآلام شيء فهو يقدر على ضبط نفسه كيلا تنقله
عن السعادة إلى ضدها بل لا تخرجه عن حد السعادة ألبتة. ولو ابتلى ببلايا
أيوب عليه السلام وأضعافها ما اخرجه عن حد السعادة. وذلك لما يجد في نفسه
من المحافظة على شروط الشجاعة والصبر على ما يجزع منه أصحاب خور الطباع
فيكون سروره أولا بذاته وبالأحاديث الجميلة التي تنشر عنه ويرى أن القاتل
الذي يدعي الشطارة والمصارع الذي يهوي الغلبة كل واحد منهما يصبر على
شدائد عظيمة من تقطيع أعضاء نفسه وترك الشهوات التي يتمكن منها طلبا لما
يحصل له من الغلبة وانتشار الصيت فيرى نفسه أحرى وأولى منهما بالصبر إذا
كان غرضه أشرف وصيته في الفضلاء أبلغ وأشهر وأكرم ولأنه بالصبر إذا كان
غرضه أشرف وصيته في الفضلاء أبلغ وأشهر وأكرم ولأنه " يسعد في نفسه ثم
يصير قدوة لغيره. وأرسطو طاليس يقول: إن بعض الأشياء تعرض من سوء البخت
بما يكون يسيرا سهل المحتمل. فإذا عرض للإنسان وأحتمله لم يكن فيه دلالة
على كبر نفسه وعظم همته. ومن لم يكن سعيدا ولا سبقت له رياسة بهذه الصناعة
الشريفة من تهذيب الأخلاق فإنه سينفعل إنفعالا قويا فيعرض له عند حلول
المصائب إحدى الحالتين: أما الإضطراب الفاحش والألم الشديد والخروج بها
إلى الحد الذي يرثى له ويرحم وأما أن يتشبه بالسعداء ويسمع مواعظهم فيظهر
الصبر والسكون إلا أنه جزع الباطن متألم الضميرز وكما أن الأعضاء المفلوجة
إذا حركت إلى اليمين تحركت إلى الشمال كذلك تكون حركات نفوس الأشرار تتحرك
إلى خلاف ما يحملونها عليه من الجميل أعني إذا تشبهوا بالأجواد وأهل
العدالة كانت هذه حالهم " .
رأى أرسطوطاليس في بقاء النفس
ومما يستدل به من كلام أرسطوطاليس على أنه كان يقول ببقاء النفس والمعاد: كلامه المتداول في كتاب الأخلاق وهو هذا قال " قد حكمنا أن السعادة شيء ثابت غير متغير وقد علمنا أيضا أن الإنسان قد تلحقه تغيرات كثيرة واتفاقات شتى. فإنه قد يمكن لمن لمن هو أرغد الناس عيشا أن يصاب بمصائب عظيمة كمارمز في برنامس. ومن يتفق له هذه المصائب ومات عليها فليس يسميه أحد من الناس سعيدا. وليس ينبغي على هذا القياس أن يسمي إنسان من الناس سعيدا ما دام حيا بل ينتظر به آخر عمره ثم يحكم عليه.فالإنسان إذا أنما يصير سعيدا إذا مات. إلا أن هذا قول في غاية الشناعة إذا كنا نقول أن السعادة هي خير ما. ثم قال في هذا الموضع أيضا موضع شك. ثم قال في هذا الموضع أيضا موضع شك فإنه قد يظن بالميت أن يلحقه خير وشر إذ يلحق الحي أيضا وهو لا يحس به مثل الكرامة أو الهوان واستقامة أمر الأولاد وأولاد الأولاد. ففي هذه الأشياء خير لأنه قد يمكن فيمن عاش عمره كله إلى أن يبلغ الشيخوخة سعيدا وتوفى على هذا السبيل أن يلحقه مثل هذه التغيرات في أولاده حتى يكون بعضهم خيارا حسن السيرة وبعضهم يضد ذلك. ومن البين أنه قد يمكن أن يوجد بين الآباء والأولاد تباين وإختلاف بكل جهة. ولكن من المنكر أن يكون الميت بتغير غيره يصير مرة سعيدا ومرةأخرى شقيا. ومن المنكر أن لا تكون أمور الأولاد متصلة بالوالدين في وقت من الأوقات. ولكن ينبغي أن نعود إلى ما كان الشك واقعا فيه. فهذا الشك الذي أورده أرسطوطاليس على نفسه في هذا الموضع هو شك من يعتقد أن للإنسان بعد موته أحوالا وأنه يتصل به لا محالة من أمور أولاده وأولاد اولاده أحوال مختلفة بحسب أخلاق سير الأولاد. فكيف تقول ليت شعري في الإنسان إذا مات سعيدا ثم لحقه من شقا بعض أولاده أو سوء سيرة من يحيا من نسله ما يكون ضد سيرته وهو حي فإنه أن غير سعادته كان هذا شنيعا وإن لم يلحقه أيضا شيء.
من ذلك كان أيضا شنيعا. ثم أرسطوطاليس يحل
هذا الشك بأن يقول ما هذا معناه: أن سيرة الإنسان ينبغي أن تكون سيرة
محمودة لأنه يختار في كل ما يعرض له أفضل الأعمال من الصبر مرة ومن إختيار
الفضل فالأفضل مرة. ومن التصرف في الأموال إذا اتسع فيها وحسن التجمل إذا
عدمها ليكون سعيدا في جميع أحواله غير منتقل عن السعادة بوجه من الوجوه.
فالسعيد
إذا ورد عليه نحس عظيم جعل سيرته أكثر سعادة لأنه يداريه مدارة جميلة
ويصبر على الشدائد صبرا حسنا. ومتى لم يفعل ذلك كدر سعادته ونغضها وجلب له
أحزانا وغموما تعوقه عن أفعال كثيرة. والجميل إذا ظهر من السعداء في هذه
الأحوال والأفعال كان أشد إشراقا وحسنا وذلك إذا احتمل ما كبر وعظم من
المصائب احتمالا سهلا بعد أن لا يكون ذلك لا لعدم حسه ولا لنقصان فهمه
بالأمور بل لشهامته وكبر نفسه قال: إذا كانت الأفعال هي ملاك السيرة كما
قلنا فليس يكون أحد من السعداء شقيا لأنه ليس يفعل في وقت من الأوقات
أفعالا مرذولة. فإذا كان هكذا فالسعيد أبدا يكون مغبوطا وإن حلت به
المصائب التي حلت ببرنامس ولا يكون أيضا شقيا ولا سريع التنقل من ذلك لأنه
ليس ينتقل عن السعادة بسهولة ولا تنقله عنها الأوقات اليسيرة بل لا تنقله
عنها الآفات العظيمة الكثيرة وليس يكون سعيدا إذا نالته هذه الأمور زمانا
يسيرا بل إذا ظفر بأمور جميلة في زمان طويل. ثم قال بعد قليل: وأما حال
الإنسان بعد موته فالقول بأن الآفات التي تعرض لأولاد الميت وأصدقائه
بأجمعهم ليست تتعلق به أصلا مضاد لما يعتقده جميع الناس. وإذا كانت الأمور
العارضة لهؤلاء كثيرة متيقنة وكان بعضها يتعدى إلى الميت أكثر وبعضها أقل
صارت قسمتنا إياها إلى الأشياء الجزئية بلا نهاية.
وأما إذا قيل قولا
كليا وعلى طريق الرسم فخليق أن نكتفي بما نقوله فيها وهو أنه كما أن
الآفات التي تعرض للميت في حياته بعضها يثقل عليه إحتماله ويثلم في سيرته
وبعضها يخف عليه احتماله كذلك يكون حاله فيما يعرض لأولاده وأصدقائه وكل
واحد من العوارض التي تعرض للأحياء مخالف لما يعرض لهم إذا ماتوا أكثر من
مخالفة كل ما يضرب به المثل ويشبه إن كان يصل إليهم من هذه الأشياء شيء
خيرا كان أو شرا أن يكون يسيرا نزرا بمقدار ما لا يجعل غير السعيد سعيدا
ولا ينتزع السعادة من السعداء. هذا حل أرسطوطاليس للشك الذي أورده.
لذة السعادة
ولما قلنا أن السعادة ألذ الأشياء وأفضلها وأجودها وأوضحها وجب أن يبين وجه اللذة فيها بأتم بيان كما قلناه فيما مضى. أن اللذة تنقسم إلى قسمين أحدهما لذة انفعالية والأخرى لذة فعلية أي فاعلة. فأما اللذة الإنفعالية فهي شبيهة بلذة الإناث واللذة الفاعلة تشبه لذة الذكور. ولذلك صارت اللذة الأنفعالية هي التي تشاركنا في الحيوانات التي ليست بناطقة وذلك أنها مقترنة بالشهوات ومحبة الإنتقام وهي انفعالات النفسين البهيميتين. وأما اللذة الأخرى فهي الفاعلة وهي التي يختص بها الحيوان الناطق ولأنها غير هيولانية ولا منفعلة انفعالا لأنها صارت لذة تامة وتلك ناقصة وهذه ذاتية وتلك عرضية. وأعني بالذاتية والعرضية أن اللذات الحسية المقترنة بالشهوات تزول سريعا وتنقضي وشيكا بل تنقلب لذاتها فتصير غير لذات بل تصير آلاما كثيرة أو مكروهة بشعة مستقبحة وهذه أضداد اللذة ومقابلاتها. وأما اللذة الذاتية فإنها لا تصير في وقت آخر غير لذة ولا تنتقل عن حالتها بل هي ثابتة أبدا. وإذا كانت كذلك فقد صح حكمنا ووضح أن السعيد تكون لذته ذاتية لا عرضية وعقلية لا حسبة وفعلية لا انفعالية والهية لا بهيمية. ولذلك قالت الحكماء أن اللذة إذا كانت صحيحة ساقت البدن من النقص إلى التمام ومن السقم إلى الصحة.وكذلك تسوق النفس من الجهل إلى العلم ومن الرذيلة إلى الفضيلة. إلا أن ههنا سرا ينبغي أن يقف عليه المتعلم وهو أن ميله إلى اللذة الحسية ميل قوي جدا وشوقه إليها شوق مزعج ولا تزيد العادة في قوة الطبع الذي لنا كبير زيادة لفرط ما جبلنا عليه في البدء من القوة والشوق. ولذلك متى كانت هذه اللذة حسية قبيحة جدا ثم مال الطبع إليها بافراط وانفعل عنها بقوة استحسن الإنسان فيها كل قبيح وهون على نفسه منها كل صعب ولا يرى موضع الغلط ولا مكان القبيح حتى تبصره الحكمة. وأما اللذة العقلية الجميلة فأمرها بالضد.
وذلك ان الطبع يكرهها فإن انصرف الإنسن إليها
بمعرفته وتمييزه احتاج فيها إلى صبر ورياضة حتى إذا تبصر فيها وتدرب لها
إنكشف له حسها وبهاؤها، وصارت عنده بمكان في الحسن. ومن هنا تبين أن
الإنسان في إبتداء تكوينه محتاج إلى سياسة الوالدين ثم إلى الشريعة
الإلهية والدين القيم حتى تهديه وتقومه إلى الحكم البالغة ليتولى تدبير
نفسه إلى آخر عمره. وقد تبين مع ذلك تعلق السعادة بالجود. وذلك أنا قد
بينا لذة فاعلة ولذة الفاعل أبدا تكون في الإعطاء ولذة المنفعل أبدا تكون
في الأخذ. ولا تظهر لذة السعيد إلا بإبراز فضائله وإظهار حكمته ووضعها
كفائته في مواضعها وكذلك البناء الحاذق والصانع اللطيف والموسيقاني
المحسن. وبالجملة كل صانع حاذق فاضل في صناعته ينسر بإظهار فضائله
وإذاعتها بين أهلها ومستحقيها. وهذا هو معنى الجود إلا أن الجود بأعلى
الأشياء وأكرمها أفضل وأشرف من الجود بأدونها وأخسها وقد عرض لهذا الجود
مع شرفه وعلو مرتبته ضد ما عرض لذلك الجود الآخر مع نزارته وقلته. وذلك أن
صاحب الأموال والمقتنيات الخارجة كلها ينتقص ماله بالإنفاق وينثلم بالبذل
وتفني ذخائره. وأما صاحب السعادة العامة فإن أمواله لا تنقص بالإنفاق بل
تزيد ولا تفنى ذخائره بالتبذير بل تنمو. وتلك معرضة للآفات الكثيرة من
الأعداء واللصوص وسائر المتسلطين وهذه محروسة من كل آفة لا سبيل للأشرار
والأعداء إليها بوجه ولا سبب. فقد ظهرت لذة السعيد كيف تكون ومن أين
تبتدىء وإلى أين تنتهي وكيف يكون السرور الحقيقي واللذة الذاتية. وتبين
أيضا أنها أبدية وتامة وإلهية وأن ضدها هو الشقاء لذاته بالضد وعلى العكس
أعني أن لذاته كلها عرضية ومنتقلة عن طبائعها إلى أضدادها حتى مؤلمة أو
مكروهة وأنها غير إلهية بل شيطانية وغير ممدوحة بل هي مذمومة. وذلك بأن
ينظر في السعادة هل هي ممدوحة. فإن ارسطوطاليس يقول أن الأشياء التي هي في
غاية الفضل لا يوجد لها مدح لأنها أفضل وأمدح وأجل من أن تمدح قال: وذلك
أنا قد ننسب المتأهلين والخيار من الناس إلى السعادة وليس يوجد أحد من
الناس يمدح السعادة نفسها كما يمدح العدل. لكنه يجلها ويكرمها إلى أنها
أمر إلهي بالأشياء التي هي أفضل من المدح وهو الله تعالى وإلى الخير فإن
المدح هو الفضيلة والعمل بها. ثم انتهى كلامه هذا إلى أن قال: فالله تعالى
أكرم وأشرف من أن يمدح بل إنما يمجدونه ونحن نمجد الله تعالى ونقدسه
تمجيدا كثيرا.
وأما السعادة فلأنها أمر إلهي وإنما تفعل الأشياء كلها
لأجلها فهي كذلك أيضا ممجدة. فعلى هذا الأمر ينبغي أن لا تمدح السعادة
لأنها أجل من كل مدح بل نمجدها في نفسها وتمدح الأمور كلها بها وبقدر
قسطها منها.
المقالة الرابعة
(ظهور الفضائل ممن ليس بسعيد ولا فاضل) قد قلنا فيما سلف أن السعادة تظهر في الأفعال من العدالة والشجاعة والعفة وسائر ما تحت هذه الأنواع التي أحصيناها وحددناها.وهذه الأفعال قد تظهر ممن ليس بسعيد ولا فاضل. وذلك أنه قد يعمل بعض الناس عمل العدول وليس بعادل ويعمل عمل الشجعان وليس بشجاع ويعمل عمل الإعفاء وليس بعفيف. مثال ذلك أن من ترك الشهوات من المآكل والمشارب وسائر اللذات التي ينهمك فيها غيره إما أنه ينتظر منها أكثر مما يحضره وإما لأنه لا يعرفها ولم يباشرها كالأعراب الذين يبعدون عن البلاد وكالرعاة في البوادي وقلل الجبال. وإما لأنه ممتلىء مما يجده ويحضره وإما لجمود شهوته ونقصان تركيبه. وإما لأنه استشعر خوفا من تناولها مكروها يلحقه بسببها. وإما لأنه ممنوع منها. فإن هؤلاء كلهم يعملون عمل الإعفاء وليسوا بإعفاء على الحقيقة وإنما يسمى عفيفا على الحقيقة من وفي العفة حدها المذكور فيما تقدم واختارها لنفسها لا لغرض آخر غيرها وآثرها لأنها فضيلة ثم تناول كل واحدة من شهواته بمقدار الحاجة ومن الوجه الذي يعمل أعمال الشجعان وليس بشجاع. وذلك أن من باشر الحروب وأقدم على ركوب الأهوال لبعض مايوصل إليه المال أو لبعض الرغبات التي لا تحد كثرة فإن الأهوال لبعض ما يوصل إليه المال أو لبعض ما يوصل إليه المال أو لبعض الرغبات التي لا تحد كثرة فإن مثل هذا يعمل عمل الشجعان ولكن يعمله بطبيعة الشره لا بطبيعة الفضيلة التي تدعي شجاعة. وكل من كان أكثر إقداما واصبر على الأهوال لهذه الأحوال يجب أن يكون أكثر شرها ونهما لا أكثر شجاعة. وذلك أنه يخاطر بنفسه الشريفة ويصبر على المكاره العظيمة طمعا في المال وما يصل إليه بالمال. وقد رأينا أهل الشقاوة يعملون عمل الإعفاء وعمل الشجعان وهم أبعد الناس عن كل فضيلة. وذلك أنهم يصبرون عن الشهوات كلها ويصبرون على عقوبات السلطان وضرب السياط وتقطيع الأعضاء والجراحات التي لا يؤمن منها وينتهون فيها لأقصى الصبر على الصلب وثمل العيون وقطع الأيدي والأرجل وضروب التمثيل طلبا لإسم وذكر بين قوم في مثل حالهم من سوء الإختيار ونقصان الفضائل. وقد يعمل أيضا عمل الشجعان من يخاف لأئمة عشيرته أوعقوبة سلطان أو خوف سقوط جاهه أو ما أشبه ذلك.
وقد يعمل عمل الشجعان من اتفق له مرارا كثيرة أن يغلب أقرانه فهو يقدم ثقة منه بالعادة الجارية وجهلا بمواقع الإتفاقات. وقد يعمل عمل الشجعان العشاق وذلك أنهم يركبون الأهوال في طلب المعشوق لرغبتهم في الفجور أو لحرصهم على متعة العين منه لا لطلب الفضيلة ولا لإختيار الموت الجميل على الحياة الرديئة كما يفعل الشجاع بالحقيقة. وأما شجاعة الأسد. وذلك أنها قد وثقت بقوتها وأنها تفوق غيرها فهي تقدم لا بطبيعة الشجاعة بل لتمام القدرة وثقة النفس والغلبة. وهو كصاحب السلاح منا إذا قدم على الأعزل. وليست هذه شجاعة مع عدم الإختيار الذي يستعمله الشجاع وذلك أن الشجاع خوفه من الأمر أشد من خوفه من الموت ولذلك يختار الموت الجميل على الحياة القبيحة. على أن لذة الشجاع ليست تكون في مبادىء أموره فإن مباديء الأمور تكون مؤذية له لكنها تكون في عواقب الأمور وتكون أيضا باقية مدة عمره وبعد عمره لا سيما إذا حامى عن دينه وعن اعتقاداته الصحيحة في وحدانية الله عز وجل والشريعة التي هي سياسة الله وسنته العادلة التي بها مصالح العباد في الدنيا والآخرة. فإن مثل هذا فكر في قصر مدة عمره وعلم أنه لا محالة يحامي عن دينه ويمنع العدو من استباحة حريمه والتغلب على مدينته ويأنف من الفرار ويعلم أن الجبان إذا اختار الفرار فإنما يستبقي شيئا هو لا محالة فإن زائل وأن تأخر أياما معدودة. ثم هو في هذه الحياة اليسيرة ممفوت مكدر الحياة بالذل وضروب الصغار. وهذه حال الشجاع مع قوى نفسه أعني بمقاومة شهواته واستسلامه لذات الشجاعة بعينها. ومن سمع كلام الإمام صلوات الله عليه الذي صدوره عن حقيقة الشجاع إذ قال لأصحابه: {أيها الناس إن لم تقتلوا تموتوا والذي نفس ابن أب يطالب بيده لألف ضربة بالسيف على الرأس أهون من ميتة على الفراش}. تبين له أن جميع ما أحصيناه للإنسان ليس بمعدود فيها وإن كان يشبهها بالصورة. ذلك أنه ليس كل من يقدم على الأهوال فهو شجاع ولا كل من لا يخاف من الفضائح فهو شجاع. وذلك أن من لا يفزع من ذهاب شرفه أوف ضيحة حرمه أو عند حدوث الرجفات والزلازل والصواعق أو الزمانة في الأمراض أو عدم الإخوان والأصدقاء أو عند إضطراب البحر وخول الأمواج والهواء الهائج فهو بأن يوصف بالجنون مرة وبالقحة مرة أولى بأن يوصف بالشجاعة.
وكذلك من خاطر بنفسه في وقت الأمن والطمأنينة بأن
يثب من سطح عال أو يصعد مرتقى صعبا أو يحمل نفسه على خوض ماء غزير وهو لا
يحسن السباحة أو يساور جملا هائجا أو ثورا صعبا او فرسا لم يرض من غير
ضرورة تدعوه إلى ذلك بل مرآة بالشجاعة وإظهار مرتبة الشجعان فهو بأن يسمى
مطرمذا مائقا أولى منه بأن يسمى شجاعا. وأما من خنق نفسه خوفا من الفقر أو
الذل أو أهلكها بالسم وما أشبهه من باب الضيم فهو بأن يوصف بالجبن أولى
منه بأن يوصف بالشجاعة. وذلك أن الإقدام وقع منه بطبيعة الجبن لا بطبيعة
الشجاعة فإن الشجاع يصير على مايرد عليه من الشدائد صبرا جميلا ويعمل
أعمالا تليق بتلك الحال كما شرحناه فيما تقدم. ولذلك يجب أن يعظم الشجاع
ويشح بنفسه وحقيق على السلطان خاصة والقيم بأمر الدين والملك أن ينافس فيه
ويجل قدره ويعلي خطره ويميزه عن سائر من يتشبه به ممن ذكرناه. فقد تبين من
جميع ما قلناه أن الشجاع هو الذي يستهين بالشدائد في الأمور الجميلة ويصبر
على الأمور الهائلة ويستخف بما يستعظمه عوام الناس حتى بالموت لإختيار
الأمر الأفضل ولا يحزن على مالا درك فيه ولا يضطرب عندما يفدحه من المصائب
ويكون غضبه إذا غضب بمقدار ما يجب وعلى من يجب وفي الوقت الذي يجب. وكذلك
يكون انتقامه على هذه الشرائط فإن الحكماء قالوا أن من لاينتقم يلحق قلبه
ذبول فإذا انتقم عاد إلى حالته من النشاط وهذا الإنتقام إذا كان بحسب
الشجاعة كان محمودا وإذا لم يكن كذلك كان مذموما. فقد نقل إلينا في
الأخبار المأثورة عمن أقدم على سلطان قوي ورام أن ينتقم منه فأهلك نفسه من
غير أن يضر سلطانه روايات كثيرة وكذلك حال من أقدم على قرن قوي أو خصم ألد
لا يستطيع مقاومته فإن الإنتقام منه يعود وبالا عليه وزيادة في الذل
والعجز. فإذا ليست تنم شرائط الشجاعة والعفة إلا للحكيم الذي يستعمل كل
شيء في موضعه الخاص به ويقدر أقساط العقل له. فكل شجاع عفيف حكيم وكل حكيم
شجاع عفيف وهذه الحال بعينها تظهر فيمن عمل عمل الإسخياء وليس بسخي. وذلك
أن من بذل أمواله في شهواته طلبا للسمعة والرياء أو تقربا إلى السلطان أو
لدفع مضرة عن نفسه وحرمه وأولاده أو بذلها لمن لا يستحق من أهل الشر
أوالملهين أو المساخرين أو بذلها لطمع في أكثر منها على سبيل التجارة
والمرابحة فكل هؤلاء يعمل عمل الإسخياء وليس بسخي. أما بعضهم فيبذل ماله
بطبيعة الشره وأما بعضهم فبطبيعة الطرمذة والرياء وبعضهم على طريق
الإزدياد من المال والربح فيه وأما بعضهم فعلى سبيل التبذير وقلة المعرفة
بقدر المال. وهذا أكثر ما يعرض للوارث ولمن لا يتعب في اكتساب المال فلا
يعرف صعوبة الأمر فيه. وذلك أن المال صعب الإكتساب سهل الإنفاق والتفرقة
قد شبهه الحكماء بمن يرفع حملا ثقيلا إلى قلة جبل ثم يرسله فإن الأمر في
ترقيته واصعاده صعب ولكن إرساله من هناك أمر سهل.
الحاجة إلى المال واكتسابه بالطرق الشريفة العادلة
الحاجة إلى المال ضرورية في العيش وهو نافع في إظهار الحكمة والفضيلة ومن اكتسبه من وجهه صعب عليه. وذلك أن المكاسب الجميلة قليلة ووجوهها يسيرة عند الرجل العادل الحر وأما غير العادل الحر فليس يبالي كيف اكتسبه ومن أين وصل إليه ولأجل ذلك يوجد كثير من الأحرار والفضلاء ناقصي الحظ منه. ويوجدون أيضا ذامين للبخت شاكين منه، وأما أضدادهم فلأجل أنهم يكتسبون المال من وجوه الخيانات ولا يبالون كيف وصل إليهم فإنهم يوجدون أبدا وافري الحظ منه وأسمى النفقات شاكرين لبخوتهم والعامة يغبطونهم ويحسدونهم. إلا أن لعاقل إذا رأى نفسه وهو برىء من المذمات نقي العرض من السوآت لم يتدنس بالقبيح منالمكاسب ولم يتطرق إليه بخيانة ولا سرقة ولا ظلم لمن هو دونه أو مثله وتجنب فيه وجوه العار والفضائح كالقيادة والخداع وترويج السلع القبيحة علىالملوك واستنزالهم عن أموالهم بالخدع والمكر ومساعتهم على الفواحش وتحسين القبائح فيما يوافق هواهم، وما يجري مجرى ذلك من السعاية والنميمة والغيبة وضروب الفساد التي يرتكبها طلاب المال من غير وجهه بضروب المغابنات ووجوه الظلم يسر بنفسه ويعتاض من المال الراحة والمحمدة فلا يلوم البخت ولا يبغض الدول ولا يحسد أصحاب الأموال المكتسبة من غير وجوهها الجميلة.فهذه أحوال المكتسبين للأموال ومنفقيها وكذلك حال من عمل عمل
العدول وليس بعدل. وذلك أنه إذا عدل في بعض الأمور مراآة ليصل به إلى
كرامة أو مال أو غير ذلك من الشهوات أو لغرض آخر مما عددناه فيما تقدم
فليس يسمي عادلا وإنما يعمل عمل العدول للغرض الذي يقصده. وينبغي أن ينسب
فعله إلى غرضه فإنه بحسب هذا يفعل ذلك كما قلنا وشرحنا.
العادل
فأما العادل بالحقيقة فهو الذي قواه وأفعاله وأحواله كلها حتى لا يزيد بعضها على بعض ثم يروم ذلك فيما هوخارج عنه من المعاملاب والكرامات ويقصد في جميع ذلك فضيلة العدالة نفسها لا غرضا آخر سواها وإنما يتم له ذلك إذا كانت له هيئة نفسانية أدبية تصدر عنها أفعاله كلها بحسبها. ولما كانت العدالة وسطا بين أطراف وهيئة يقتدر بها على رد الزائد والناقص إليها صارت أتم الفضائل وأشبهها بالوحدة. وأعني بذلك أن لوحدة هي التي لها الشرف الأعلى والرتبة القصوى. وكل كثرة لا يضبطها معنى يوحدها فلا قوام لها ولا نبات. والزيادة والنقصان والكثرة والقلة هي التي تفسد الأشياء إذا لم يكن بينها مناسبة تحفظ عليها الإعتدال بوجه ما. فالإعتدال هو الذي يرد إليها ظل الوحدة ومعناها. وهو الذي يلبسها شرف الوحدة ويزيل عنها رذيلة الكثرة والتفاوت والإضطراب الذي لا يحد ولا يضبط بالمساواة التي هي خليفة الوحدة في جميع الكثرات واشتقاق هذا الإسم يدلك على معناه. وذلك أن العدل في الأحمال والإعتدال في الأثقال والعدالة في الأفعال مشتقة من معنى المساواة والمساواة هي أشرف النسب المذكورة في صناعة الأرتماطيقي ولذلك لا تنقسم ولا يوجد لها أنواع وإنما هي وحدة في معناها أو ظل للوحدة. فإذا لم نجد المساواة التي هي المثل بالحقيقة في الكثرة عدلنا إلى النسب المذكورة التي تنحل إليها وتعود إلى حقيقتها. وذلك أنا حينئذ نضطر إلى ان نقول نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا. ولذلك لا توجد النسبة إلا بين أربعة أو ثلاثة يتكرر فيها الوسط فتصير أيضا أربعة والنسبة الأولى تسمى منفصلة والثانية تسمى متصلة. ومثال الأولى ا ب ج د فنقول نسبة (1) إلى (ب) إلى (د). ومثال الثانية أن نأخذ الباء مشتركا فنقول نسبة (1) إلى (ب) كنسبة (ب) إلى (ج) وهذه النسبة توجد بين ثلاثة أشياء.وهي النسبة العددية والنسبة المساحية والنسبة التأليفية وجميع ذلك مبين مشروح في المختصر الذي عملناه في صناعة العدد. وأما سائر النسب فراجعة إليها ولذلك عظمها الأوائل واستخرجوا بها العلوم الجمة الشريفة ولما كانت نسبة المساواة عزيزة لأنها نظيرة الوحدة عدلنا إلى حفظ هذه النسب الأخر في الأمور الكثيرة التي تلابسها لأنها عائدة إليها وغير خارجة عنها فنقول:
مواضع العدالةإن العدالة موجودة في ثلاثة مواضع: أحدها قسمة الأموال والكرامات والثاني قسمة المعاملات الإرادية كالبيع والشراء والمعاوضات. والثالث قسمة الأشياء التي وقع فيها ظلم وتعد. فأما العدالة في الأمور التي تكون في القسم الأول فتكون بالنسبة المنفصلة التي بين الأربعة أعني أن تكون نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع. مثال ذلك أن يقال نسبة هذا الإنسان إلى هذه الكرامة أو إلى هذا المال كنسبة كل من كان في مثل مرتبته إلى مثل قسطه فإذا يجب أن يوفر علهي ويسلم، وأما في الأمور التي تكون في القسم الثاني أعني المعاملات والمعاوضات فيكون بالنسبة المنفصلة مرة وبالنسبة المتصلة له أخرى. مثاله أن تقول نسبة هذا البزاز إلىهذا الإسكاف كنسبة هذا الثوب إلى هذا لخف ثم ليس يمنع مانع أن تقول نسبة البزار إلى الإسكاف كنسبة الإسكاف إلى النجار أو تقول: نسبة الثوب إلى الخف كنسبة الخف إلى الكرسي. ويتبين لك من هذين المثالين أن النسبة الأولى تكون بالعمق فقط والنسبة الثانية تكون بالعرض والعمق جميعا أعني أن الأولى تقع بين الكليين والجزئيين وهو بالعمق أشبه. والثانية تقع بالعرض في الجزئيين وقد تقع بين الكلين والجزئيين أيضا.
وأما العدالة التي تقع في المظالم والأمور
القسمية فهي بالنسبة المساحية أشبه وذلك أن الإنسان متى كان على نسبة من
إنسان آخر فأبطل هذه النسبة بحيف أو ضرر يلحقه به، فإن العدالة توجب أن
يلحق به ضرر مثله ليعود التناسب إلى ما كان عليه. فالعادل من شأنه أن
يساوي بين الأشياء الغير المتساوية.
مثال ذلك أن الخط إذا قسم بقسمين
غير متساويين نقص من الزائد وزاد على الناقص حتى يحصل له التساوي ويذهب
عنه معنى القلة والكثرة ومعنى الزيادة والنقصان وكذلك الخفة والثقل وجميع
ما أشبه ذلك. ولكن ينبغي أن يكون عالما بطبيعة الوسط حتى يمكنه أن يرد
الطرفين إليه مثال ذلك الربح والخسران فإنهما في باب المعاملات طرفان
أحدهما زيادة والآخر نقصان فإذا أخذ أقل مما يجب صار إلى جانب النقصان وإن
أخذ أكثر مما يجب كان خارجا إلى جانب الزيادة.
لزوم الشريعة في المعاملات
والشريعة هي التي ترسم في كل واحد من هذه الأشياء التوسط والإعتدال لأن الناس هم مدنيون بالطيع ولا يتم لهم عيش إلا بالتعاون فيجب أن بعضهم يخدم بعضا ويأخذ بعضهم من بعض ويعطي بعضهم بعضا فهم يطلبون المكافأة المناسبة. فإذا أخذ الإسكاف من النجار عمله وأعطاه عمله فهي المعاوضة إذا كان العملان متساويين ولكن ليس يمنع مانع أن يكون عمل الواحد خيرا من عمل الآخر فيكون الدينار هو المقوم والمسوي بينهما.فالدينار هو عدل ومتوسط إلا انه ساكت والإنسان الناطق هو الذي يستعمله ويقوم به جمي الأمور التي تكون بالمعاملات حتى تجري على إستقامة ونظام ومناسبة صحيحة عادلة. ولذلك يستعان بالحاكم الذي هو عدل ناطق إذا لم يستقم الأمر بين الخصمين بالدينار الذي هو عدل ساكت وأرسطوطاليس يقول: {إن الدينار ناموس عادل " ومعنى الناموس في لغته السياسية والتدبير وما أشبه ذلك. فهو يقول في كتابه المعروف بنيقوماخيا " إن الناموس الأكبر هو من عند الله تبارك وتعالى والحاكم ناموس ثاني من قبله والدينار ناموس ثالث. فناموس الله تعالى قدوة النواميس كلها " يعني الشريعة والحاكم الثاني مقتد به والدينار مقتد ثالث وإنما قومت الأشياء المختلفة بالأثمان المختلفة لتصح المشاركات والمعاملات ويتبين وجه الأخذ والإعطاء. فالدينار هو الذي يسوي بين المختلفات ويزيد في شيء وينقص في آخر حتى يحصل بينهما الإعتدال فتستوي المعاملة بين الفلاح والنجار مثلا. وهذا هو العدل المدني وبالعدل المدني عمرت المدن وبالجور المدني خربت المدن. وليس يمنع مانع من أن يكون عمل يسير يساوي عملا كثيرا مثلا ذلك ان المهندس ينظر نظرا قليلا ويعمل عملا يسيرا ويساوي نظره هذا عملا كثيرا من أقوام يكدون بين يديه ويعلمون بما يرسمه. وكذلك صاحب الجيش يكون تدبيره ونظره يسيرا ولكنه يساوي أعمالا كثيرة مما يحارب بين يديه ويعمل الأعمال الثقيلة العظيمة. فالجائر يبطل التساوي وهو عند أرسطوطاليس على ثلاث منازل. فالجائر الأعظم هو الذي لا يقبل الشريعة ولا يدخل تحتها. والجائر الثاني هو الذي لا يقبل قول الحاكم العادل في معاملاته وأموره كلها. والجائر الثالث هو الذي لا يكتسب ويغتصب الأموال فيعطي نفسه أكثر مما يجب لها وغيره أقل مما يجب له قال: " فالمستمسك بالشريعة يعمل بطبيعة المساواة فيكتسب الخير والسعادة من وجوه العدالة لأن الشريعة تأمر بالأشياء المحمودة لأنها من عند الله عزوجل فلا تأمر إلا بالخير وإلا بالأشياء التي تفعل السعادة. وهي أيضا تنهى عن الرداآت البدنية وتأمر بالشجاعة وحفظ الترتيب والثبات في مصاف الجهاد. وتأمر بالعفة وتنهى عن الفسوق وعن الإفتراء والشتم والهجر وبالجملة تأمر بجميع الفضائل وتنهى عن جميع الرذائل. فالعادل يستعمل العدالة في ذاته وفي شركائه المدنيين " والجائر يستعمل الجور في ذاته وفي أصدقائه ثم في جميع شركائه المدنيين قال: {وليست العدالة جزءا من الفضيلة بل هي الفضيلة كلها ولا الجور ظاهر ينفعل بالإرداة مثل ما يكون في البيع والشراء والكفالات والقروض والعواري. وبعضها خفي ينفعل أيضا بالإرادة مثل السرقة والفجور والقيادة وخداع المماليك وشهادة الزور وبعضها غشمى على سبيل التغلب مثل التعذيب بالدهق والقيود والأغلال.
الإمام العادل
فالإمام العادل الحاكم
بالسوية يبطل هذه الأنواع ويخلف صاحب الشريعة في حفظ المساواة فهو لا يعطي
ذاته من الخيرات أكثر مما يعطي غيره. ولذلك قيل في الخبر أن الخلافة تطهر
الإنسان. قال فأما العامة فإنها تؤهل لمرتبة الإمامة التي هي الخلافة
العامة بما ذكرناه. من كان شريفا في حسبه ونسبه وبعضهم يؤهل لذلك من كان
كثير المال. وأما العقلاء فإنهم يؤهلون لذلك من كان حكيما فاضلا فإن
الحكمة والفضيلة هي التي تعطي الرياسات والسيادات الحقيقية وهي التي رتبت
الثاني والأول في مرتبتيهما وفضلتهما.
أسباب المضرات
وأسباب المضرات كلها تتفنن إلى أربعة أنواع. أحدها الشهوة والرداءة التابعة لها. والثاني الشرارة والجور التابع لها. والثالث الخطاء ويتبعه الحزن والرابع الشقاء، أما الشهوة فإنها تحمل الإنسان على الأضرار بغيره إلا أنه لا يكون مؤثرا له ولا ملتذا به. ولكنه يفعله ليصل به إلى شهوته وربما كان متألما به كارها له إلا أن قوة الشهوة تحمله على إرتكاب ما يرتكبه. وأما اشرير فإنه يتعمد الأضرار بغيره على سبيل الإيثار له والإلتذاذ به. كمن يسعى إلى السلطان ويحمله على إزالة نعمة لا يصل إليه منها شيء. ولكن يلتذ بالمكروه الذي يصل إلى غيره. وأما الخطأ فإن صاحبه لا يقصد الأضرار بغيره ولا يؤثره ولا يلتذ به بل بقصد فعلا ما فيعرض منه فعل آخر. وصاحب الفعل يحزن ويكتئب لما أتفق إليه من الخطاء. وأما الشقاء فصاحبه لا يكون هذا مبدأ فعله ولا له فيه صنع بالقصد. بل يوقعه فيه سبب آخر من خارج.وذلك كمن تصدم به دابته صديقا له فتقتله. فهذا يسمى شقيا وهو مرحوم معذور لا يجب عليه عتب ولا عقوبة. وأما السكران والغضبان والغيران إذا فعلوا فعلا قبيحا فإنهم يستحقون العتب والتفويه لأن مبتدأ أفعالهم منهم. وذلك أن السكران باختياره أزال عقله والغضبان والغيران اختارا الإنقياد بهاتين القوتين إذا هاجتا بهما، ونعود إلى ما كنا فيه من ذكر العدالة فنقول:
تقسيم العدالة
إن
ارسطوطاليس قسم العدالة إلى أقسام ثلاثة: أحدها ما يقوم به الناس لرب
العالمين. وهو أن يجري الإنسان فيما بينه وبين الخالق عزوجل على ما ينبغي
وبحسب ما يجب عليه من حقه وبقدر طاقته. وذلك أن العدل إذا كان هو اعطاء ما
يجب من يجب كما يجب. فمن المحال ان لا يكون لله تعالى الذي وهب لنا هذه
الخيرات العظيمة واجب ينبغي أن يقوم به الناس. والثاني ما يقوم به بعض
الناس لبعض من أداء الحقوق وتعظيم الرؤساء وتأدية الآمانات والنصفة في
المعاملات. والثالث ما يقومون به من حقوق أسلافهم مثل أداء الديون عنهم
وإنفاذ وصاياهم وما أشبه ذلك فهذا ما قاله ارسطوطاليس وأما تحقيق ما قاله،
مما يجب لله عز وجل وإن كان ظاهرا فأنا نقول فيه ما يليق بهذا الموضع. وهو
أن العدالة لما كانت تظهر في الأخذ والإعطاء وفي الكرامة التي ذكرناها.
وجب أن يكون لما يصل إلينا من عطيات الخالق عز وجل ونعمه التي لا تحصى حق
يقابل عليه. وذلك أن من أعطى خيرا ما وإن كان قليلا ثم لم ير أن يقابله
بضرب من المقابلة فهو جائر. فكيف به إذا أعطى جما كثيرا وأخد أخذا دائما
ثم لم يعط في مقابلته شيء البتة. ثم على قدر النعمة التي تصل إلى الإنسان
يجب أن يكون إجتهاده في المقابلة عليها. مثال ذلك أن الملك الفاضل إذا أمن
السرب وبسط العدل وأوسع العمارة وحمى الحريم وذب عن الحوزة ومنع من
التظالم ووفر الناس على ما يختارونه من مصالحهم ومعايشهم. فقد أحسن إلى كل
واحد من رعيته إحسانا يخصه في نفسه وإن كان قد عمهم بالخير واستحق من كل
واحد منهم أن يقابله بضرب من المقابلة متى قعد عنه كان جائرا إذ كان يأخذ
نعمته ولا يعطيه شيئا. لكن مقابلة الملك الفاضل من رعيته إنما تكون بإخلاص
الدعاء ونشر المحاسن وجميل الشكر وبذل الطاعة وترك المخالفة في السر
والعلانية والمحبة الصادقة والإئتمام بسيرته نحو الإستطاعة والإقتداء به
في تدبير منزله وأهله وولده وعشيرته فإن: نسبة الملك إلى مدينته ورعيته
كنسبة صاحب المنزل إلى منزله وأهله. فمن لم يقابل ذلك الإحسان بهذه الطاعة
والمحبة فقد جار وظلم وهذا الظلم وإن كان في نفسه قبيحا فإن مراتبه كثيرة.
لأن مقابلة كل نعمة إنما تكون بحسب منزلتها وموقعها وبقدر فائدتها
وعائدتها وعلى مقدار عددها. فإن كانت النعم كثيرة العدد وعظيمة الوقع فكيف
يكون حال من لا يلزم لها حقا ولا يرى عليها مقابلة بطاعة ولا شكر ولا محبة
صادقة ولا مسعاة صالحة. فإذا كان هذا معروفا غير منكور واجبا غير مجحود في
ملوكنا ورؤسائنا.
فبالأحرى أن يكون لملك الملوك الذي يصل إلينا في كل
طرفة عين ضروب إحسانه الفائض على أجسامنا ونفوسنا التي لا يقع عليها إحصاء
ولا عدد من الحقوق الواجب علينا القيام بها والنهوض بتأديتها، أترانا نجهل
النعمة الأولى علينا بالوجود ثم تتابعها متواترة بعد ذلك بالخلق الجسداني
الذي أفنى فيه صاحب كتابي التشريح ومنافع الأعضاء ألف ورقة ثم لم يبلغ بعض
ما عليه كنه الأمرز أم ترانا نجهل م اوهب لنا من نفوسنا وما ركب فيها من
القوى والملكات التي لا نهاية لها وما أمدها به من فيض العقل ونوره وبهائه
وبركاتهز وما عرضنا به للملك الأبدي والنعيم السرمدي (لا) لعمري ما يجهل
هذه النعمة إلا النعم. فإما الإنسان فيعرف من ذلك ما يضطره إليه مشاهدة
أحواله في جميع أوقاته، وإذا كان الخلاق تعالى غنيا عن معونتنا ومساعينا
فمن المحال القبيح والجور الفاحش أن نلتزم له نحن حقا ولا نقابله على هذه
الآلاء والنعم بما يزيل عنا سمة الجور والخروج عن شريطة العدل.
ما يجب على الإنسان لخالقه
إن
أرسطوطاليس لم ينص في هذ1ا الموضع علىالعبادة التي يجب أن نلتزمها لخالقنا
عز وجل غير أ،ه قال ما معناه وقد اختلفت لناس فيما ينبغي أن يقوم
بهالمخلوقون لخالقهم فبعضهم رأى أنه صلوات وصيام وخدمة هياكل ومصليات
وقرابين. وبعضهم رأى أن يقتصر على الإقرار بربوبيته والإعتراف بإحسانه
وتمجيده بحسب استطاعته وبعضهم رأى أن يتقرب إليه بأن يحسن إلى نفسه
بتزكيتها وحسن سياستها. والإحسان إلى المستحقين من أهل نوعه بالمواساة ثم
بالحكمة وبعضهم رأى اللهج بالفكر في الإلهيات والتصرف نحو المحاولات التي
يتزايد بها الإنسان من معرفة ربه عز وجل حتى تتكامل معرفته به وبحقيقة
وحدانيته وصرف الوكد إليه. وبعضهم رأى أن الواجب للرب جل ذكره على الناس
ليس سبيله واحدا ولا هو شيء بعينه يلتزمه الجميع التزاما واحدا وعلى مثال
واحد لكنه يختلف بحسب اختلاف طبقات الناس ومراتبهم من العلم فهذا ما قاله
أرسطوطاليس بألفاظه المنقولة إلى العربية. وأما الحدث من الفلاسفة فإنهم
قالوا إن عبادة الله عزوجل على ثلاثة أنواع. أحدها فيما يجب له على
الأبدان كالصلاة والصيام والسعي إلى المواقف الشريفة لمناجاة الله عزوجل.
والثاني فيما يجب له على النفوس كالإعتقادات الصحيحة وكالعلم بتوحيد الله
عز إسمه وما يستحقه من الثناء والتمجيد وكالفر فيما أفاضه على العالم من
وجوده وحكمته ثم الإتساع في هذه المعارف. والثالث فيما يجب له عند مشاركات
الناس في المدن وهي في المعاملات والمزارعات والمناكح وفي تأدية الأمانات
مع نصيحة البعض للبعض بضروب المعاونات وعند جهاج الأعداء والذب عن الحريم
وحماية الحوزة قالوا فهذه هي العبادات وهي الطرق المؤدية إلى الله عز وجل.
وهذه
الأنواع وإن كانت معدودة ومحصورة فإنها منقسمة إلى أنواع كثيرة وأقسام غير
محصاة، وللإنسان مقامات ومنازل عند الله عز وجل. فالمقام الأول للموقنين
وهو رتبة الحكماء وأجلة العلماء. والمقام الثاني مقام المحسنين. وهو رتبة
الذين يعملون بما يعملون. وهو ما ذكرناه في كتابنا هذا من الفضائل والعمل
بها والمقام الثالث مقام الأبرار وهو رتبة المصلحين وهؤلاء هم خلفاء الله
بالحقيقة في إصلاح العباد والبلاد. والمقام الرابع مقام الفائزين وهو رتبة
المخلصين في المحبة وإليها ننتهي رتبة الإتحاد وليس بعدها منزلة ولا مقام
لمخلوق ويسعد الإنسان بهذه المنازل إذا حصلت له أربع خلال. أولها الحرص
والنشاط والثاني العلوم الحقيقة والمعارف اليقينية. والثالث الحياء من
الجهل ونقصان القريحة اللذين يحدثان بالإهمال. والرابع لزوم هذه الفضائل
والترقي فيها دائما بحسب الإستطاعة فهذه أسباب الإتصال.
أسباب الإنقطاع عن الله
وأما أسباب الإنقاطات عن الله عز وجل والمساقط وهي التي تعرف باللعاين. فأولها السقوط الذي يستحق به الأعراض وتتبعه الإستهانة.والثاني السقوط الذي يستحق به الحجاب ويتبعه الإستخفاف، والثالث السقوط الذي يستحق بالطرد ويتبعه المقت. والرابع السقوط الذي يستحق به الخسأة ويتبعه البغض. وإنما يشقى لاعبد إذا حصل على أربع خلال.
أولها الكسل والبطالة ويتبعهما ضياع الزمان وفناء العمر بغير فائدة إنسانية. والثاني الغباوة والجهل المتولدان عن ترك النظر ورياضة النفس بالتعاليم التي أحصيناها في كتاب مراتب السعادات.
والثالث الوقاحة التي ينتجها إهمال النفس إذا تتبعت الشهوات وترك زمامها لركوب الخطايا والسيئات، والرابع الإنهماك الذي يحدث من الإستمرار في القبائح وترك الإنابة وهذه الأنواع الأربعة مسماة في الشريعة بأربعة أسماء، فالأول هو الزيغ والثاني هو الرين والثالث هو الغشاوة، والرابع هو الختم.
ولكل واحدة من هذه الشقاوات علاج خاص سنذكره عند مدواة أسقام النفس حتى تعود إلى الصحة بإذن الله عز وجل. وهذه الأشياء التي عددناها الآن لاخلاف بين الحكماء فيها وبين أصحاب الشرائع وإنما تختلف بالعبارات والإشارات إليها بحسب اللغات. وأفلاطون يقول إنالعدالة إذا حصلت للإنسان أشرق بهاكل واحد واحد من أجزاء النفس وذلك لحصول فضائلها أجمع فيها فيحنئذ تنهض النفس فتؤدي فعلها الخاص بها على أفضل ما يكون وهو غاية قرب الإنسان السعيد من الإله تقدس إسمه.
قال
والعدالة توسط ليس على جهة التوسط الذي في الفضائل التي تقدم ذكرها. لكن
لأنها في الوسط والجور في الطرفين. وإنما صار الجور في الطرفين لأنه زيادة
ونقصان. وذلك أن من شأن الجور طلب الزيادة والنقصان معا.
أما الزيادة
فمن النافع على الإطلاق. وأما النقصان فمن لاضار فلذلك يكون الجائر
مستعملا للزيادة والنقصان إما لنفسه فيستعمل الزيادة في النافع. وأما
لغيره فيستعمل النقصان منه، وأما في الضار فبالضد وعلى العكس. وذلك أنه
إما لنفسه فيستعمل النقصان وإما لغيره فيستعمل الزيادة والفضائل التي قلنا
أنها أوساط بين الرذائل وهي غايات ونهايات. وذلك أن الوسط ههنا نهاية لها
من كل جهة فهو في غاية البعد منها ولذلك متى بعد عن الوسط زيادة بعد قرب
من رذيلة كما قلناه فيما تقدم. فقد تبين من جميع ما قدمنا أن الفضائل كلها
إعتدالات وأن العدالة إسم يشملها ويعمها كلها وأن الشريعة لما كانت تقدر
الأفعال الإرادية التي تقع بالروية الإلهي صار المتمسك بها في معاملاته
عدلا والمخالف جائرا. فلهذا قلنا ان العدالة لقب للمتمسك بالشريعة، إلا
أنا قد قلنا مع ذلك انها هيئة نفسانية تصدر عنها هذه الفضيلة.
فتصور
الهيئة النفسانية فإنك سترى رؤية واضحة أن صاحبها ينقاد ولا محالة للشريعة
طوعا ولا يضادها بنوع من أنواع التضاد وذلك أنه إذا حافظ على المناسبات
التي ذكرناها لأنها مساواة وآثرها بعد إجالة الرأي فيها على سبيل الإختيار
لها والرغبة فيها وجب عليه موافقة الشريعة وترك مخالفتها.
وأقل ماتكون
المساواة بين اثنين ولكنها تكون في معاملة مشتركة بينهما وهو الشيء الثالث
وربما كانا شيئين كما قلنا فتصير المناسبات كما بينا بين أربعة أشياء.
وينبغي أن يعلم ان هذه الهيئة النفسانية هي غير الفعل وغير المعرفة وغيرة
القوة.
أما الفعل فلأنّا قد بينا انه قد يقع على غير هيئة نفسانية. كمن
يعمل أعمال العدالة وليس بعادل وكمن يعمل أعمال الشجاعة وليس بشجاع وأما
القوة والمعرفة فلان كل واحدة منهما هي بعينها للضدين معا. فإن العلم
بالضدين واحد وكذلك القوة على الضدين قوة واحدة. وأما لاهيئة القابلة لأحد
الضدين فهي غير الهيئة القابلة للضد الآخر. ومثال ذلك هيئة الشجاعة فإنها
غير هيئة الجبن وكذلك هيئة العفة غير هيئة الشره وهيئة العدالة غير هيئة
الجور. ثم إن العدالة والخيرية يشتركان في باب المعاملات والأخذ والإعطاء.
إلا أن العدالة تقع في اكتساب المال على الشرائط التي قدمنا القول فيها.
والخيرية تقع في إنفاق المال على الشرائط التي ذكرناها أيضا ومن شأن من
يكتسب أن يأخذ فهو بالمنفعل أشبه ومن شأن المنفق أن يعطي فهو بالفاعل
أشبه. فلهذه العلة تكون محبة الناس للخير أشد من محبتهم للعادل. إلا أن
نظام العالم بسبب العدالة أكثر منه بالخيرية. وخاصة الفضيلة هي في فعل
الخير لا في ترك الشر وخاصة محبة الناس وحمدهم في بذل المعروف لا في جمع
المال. فالخير لا يكرم المال ولا يجمعه لذاته بل ليصرفه في وجوهه التي
يكتسب بها المحبات والمحامد. ومن خاصة الخير أن لا يكون كثير المال لأنه
منفاق ولا يكون أيضا فقيرا لأنه كسوب من حيث ينبغي وهو غير متكاسل عن
الكسب ألبتة لأنه بالمال يصل إلى فضيلة الخيرية. ولذلك لا يضيع المال ولا
يستعمل فيه التبذير ولا يشح أيضا فلا يستعمل التقتير: خير عادل وليس كل
عادل خيرا.
مسألة عويصة أولى
وفي هذا الموضع مسألة
عويصة سأل عنها الحكماء أنفسهم وأجابوا عنها بجواب مقنع ويمكن أن يجاب
فيها بجواب آخر أشد إقناعا ويجب أن نذكر لاجميع وهو: أن لشاك أن يشك فيقول
إذا كانت العدالة فعلا اختياريا يتعاطاه العادل ويقصد به تحصيل الفضيلة
لنفسه والمحمدة من الناس فيجب أن يكون الجور فعلا اختياريا يتعاطاه الجائر
ويقصد به تحصيل الرذيلة لنفسه ومذمة الناس. ومن القبيح الشنيع أن يظن
بالإنسان العاقل أنه يقصد الأضرار بنفسه بعدالروية وعلى سبيل الإختيار. ثم
أجابوا عن ذلك وحلوا هذا الشك بأن قالوا أن من ارتكب فعلا يؤديه إلى ضرر
أو عذاب فإنه يكون ظالما لنفسه وضارا لها من حيث يقدر أنه ينفعها وذلك
لسوء اختياره وترك مشاورة العقل فيه. مثال ذلك الحاسد فإنه ربما جنة على
نفسه لأعلى سبيل إيثار الأضرار بها بل لأنه يظن أنه ينفعها في العاجل
بالخلاص من الأذى الذي يلحقه من الحسد. هذا جواب القوم وأما الجواب الآخر
فهو أن الإنسان لما كان ذا قوى كثيرة يسمى بمجموعها إنسانا واحدا لم ينكر
أن تصدر عنه أفعال مختلفة بحسب تلك القوى. وإنما المنكر أن يكون الشيء
الواحد البسيط ذو القوة الواحدة تقع منه بتلك القوة أفعال مختلفة لا بحسب
الآلات المختلفة ولا بقدر القابلات منه بل بتلك القوة الواحدة فقط. فهذ1
لعمري منكر شنيع ولكن الإنسان قد تبين من حاله أن له قوى كثيرة فيعمل بكل
قوة عملا مخالفا للعمل بالأخرى أعني أن صاحب الغضب إذا استشاط يختار
أفعالا مخالفة لأفعاله إذا كان ساكنا وديعا.
وكذلك صاحب الشهوة الهائجة
وصاحب النشوة الطروب فإن من شأن هؤلاء أن يستخدموا العقل الشريف في تلك
الأحوال ولا يستشيرونه ولذلك تجد العاقل إذا تغيرت أحواله تلك فصار من
الغضب إلى الرضا ومن السكر إلى الإفاقة تعجب من نفسه وقال ليت شعري كيف
اخترت تلك الأفعال القبيحة ويلحقه الندم. وإنما ذلك لأن القوة التي تهيج
به تدعوه إلى ارتكاب فعل يظنه في تلك الحال صالحا له جميلا به لتتم له
حركة القوة الهائجة به. فإذا سكن عنها وراجع عقله رأى قبح ذلك الفعل
وفساده. وقوى الإنسان التي تدعوه إلى ضروب الشهوات ومحبة الكرامات كثيرة
جدا فهو بحسب قواه الكثيرة تكون أفعاله كثيرة.
فإذا تعود الإنسان أن
تكون سيرته فاضلة ولم يقدم على شيء من أفعاله إلا بعد مطالعة العقل الصريح
وبعد مراعاة الشريعة القويمة كانت أفعاله كلها منتظمة غير مختلفة ولا
خارجة عن سنن العدل أعني المساواة التي قدمنا القول فيها.
ولهذا السبب
قلنا أن السعيد هو من اتفق له في صباه أن يأنس بالشريعة ويستسلم لها
ويتعود جميع ما تأمره به حتى إذا بلغ المبلغ الذي يمكنه به أن يعرف
الأسباب والعلل طال الحكمة فوجدها موافقة لما تقدمت عادته به فاستحكم رأيه
وقويت بصيرته ونفذت عزيمته.
مسألة عويصة ثانية
وههنا
مسألة عويصة أشد من الأولى وهو أن التفضل شيء محمود جدا وليس يقع تحت
العدالة لأن العدالة كما ذكرنا مساواة ة والتفضل زيادة وقد حكمنا أن
العدالة تجمع الفضائل كلها ولا مزيد عليها بل يجب أن تكون الزيادة عليها
مذمومة كما أن النقصان عنها مذوم ليكون شرف الوسط الذي تقدم وصفه في سائر
الأخلاق حاصلا للعدالة. فالجواب عنها ان التفضل احتياط يقع من صاحبه في
العدالة ليأمن به وقوع النقص في شيء من شرائطها وليس الوسط في كلا الطرفين
من الأخلاق على شريطة واحدة وذلك أن الزيادة في باب السخاء إذا لم تخرج
إلى باب التبذير أحسن من النقصان فيه وأشبه بالمحافظة على شرائطه فتصير
كالاحتياط فيه والأخذ بالحزم فيه. وأما العفة فإن النقصان من الوسط فيها
أحسن من الزيادة عليه وأشبه بالمحافظة على شرائطه وأبلغ في الاحتياط عليه
وأخذ الحزم فيه ومع ذلك فليس يستعمل التفضل إلا حيث تستعلم العدالة. وأعني
بذلك أن من أعطى ماله من لا يستحق شيئا منه وترك مواساة من يستحقه لا يسمى
متفضلا بل مضيعا. وإنما يكون متفضلا إذا أعطى من يستحق كل ما يستحق ثم
زاده تفضلا وهذه الزيادة ليست من الزيادة التي ذكرناها في باب السخاء لأن
تلك الزيادة ذهاب إلى الطرف الذي يسمى تبذيرا وهو مذموم ويعرف ذلك من حده
وهو بذل مالا ينبغي كمالا ينبغي في الوقت الذي لا ينبغي. فإذا التفضل غير
خارج عن شرط العدالة بل هو احتياط فيها، ولذلك قيل أن المتفضل أشرف من
العادل. فقد بان أن التفضل ليس غير العدالة بل هو العدالة مع الاحتياط
فيها وكأنه مبالغة لا يخرجها عن معناها لأن هذه الهيئة النفسانية ليست غير
تلك الهيئة بل هي. فأما الأطراف التي هي رذائل أعني الزيادة والنقصان التي
سبق القول فيهما فهي كلها هيئات مذمومة غير الهيئات المحمودة. وحدود هذه
الأشياء هي التي تحصل لك معانيها ومشاركة بعضها البعض. ومباينة بعضها
البعض. وأيضا فإن الشريعة تأمر بالعدالة أمرا كليا وليست تنحط إلى
الجزئيات وأعني بذلك أن العدالة التي هي المساواة تكون مرة في باب الكم
ومرة في باب الكيف وفي سائر المقولات وبيان ذلك أن نسبة الماء إلى الهواء
مثلا ليست تكون بالكمية بل بالكيفية ولو كانت بالكمية لوجب أن يكونا
متساويين في المساحة ولو كانا كذلك لتغالبا وأحال أحدهما الآخر إلى ذاته.
وكذلك
النار والهواء ولو أحالت هذه العناصر بعضها بعضا لفنى العالم في أقرب مدة.
ولكن الباري تقدس اسمه عدل بين هذه بالقوة فتقاومت فليس يغلب أحد الآخر
بالكلية وإنما يحيل الجزء منهاالجزء في الأطراف أعني حيث تلتقي نهاياتها.
وأما كلياتها فلا تقدر على كلياتها لأن قواها متساوية متعادلة على غاية
التسوية والتعادل.
وبهذا النوع من العدل قيل بالعدل قامت السموات
والأرض ولو رجح أحدهما على الآخر بزيادة يسير قوة لأحال الزائد الناقص
وقوى عليه فبطل العالم فسبحان القائم بالقسط لا إله إلا هو.
؟؟الشريعة
تأمر بالعدالة ولما كانت الشريعة تأمر بالعدالة الكاملة لم تأمر بالتفضل
الكلي بل ندبت إليه ندبا يستعمل في الجزئيات التي لا يمكن أن تعين عليها
لأنها بلا نهاية وجزمت القول في العدالة الكلية لأنها محصورة يمكن أن تعين
عليها وقد تبين أيضا مما قدمنا أن التفضل إنما يكون في العدالة التي تخص
الإنسان في نفسه. أعني تسوية المعاملة أولا فيما بينه وبين غيره ثم
الإستظهار فيه والإحتياط عليه بما يكون تفضلا ولو كان حاكما بين قوم ولا
نصيب له في تلك الحكومة لم يجز له التفضل ولم يسعه إلا العدل المحض
والتسوية الصحيحة بلا زيادة ولا نقصان. وتبين أيضا أن الهيئة التي تصدر
عنها الأفعال العادلة متى نسبت إلى صاحبها سميت فضيلة وإذا نسبت إلى من
يعامله بها سميت عدالة وإذا اعتبرت بذاتها سميت ملكة نفسانية.
فاستعمال
المر العاقل العدل على نفسه أو ما يلزمه ويجب عليه. وقد ذكرنا فيما تقدم
كيف يفعل ذلك وبينا كيف يعدل قواه الكثيرة إذا هاج به بعضها وأشرنا إلى
أجناس هذه القوى الكثيرة وأن بعضها يكون بالشهوات المختلفة وبعضها بطلب
الكرامات الكثيرة وأنها إذا تغالبت وتهايجت حدث في الإنسان باضطرابها
أنواع الشر وجذبته كل واحدة منها إلى ما يوافقها وهكذا سبيل كل مركب من
كثرة إذا لم يكن لها رئيس واحد ينظمها ويوحدها. وارسطوطاليس يشبه من كان
كذلك بمن يجذب من جهات كثيرة فيقطع بينها وينشق بحسب تلك الجهات وقواها.
وليس
ينظم هذه الكثرة التي ركب الإنسان منها إلا الرئيس الواحد الموهوب له من
الفطرة. أعني العقل الذي به تميز من البهائم وهو خليفة الله عز وجل عنده
فإن هذه القوى كلها إذا ساسها العقل انتظمت وزال عنها سوء النظام الذي
يحدث من الكثرة وجميع ما ذكرنا من إصلاح الأخلاق مبني عليه. فإذا تم
للإنسان ذلك أعني أن يعدل على نفسه وأحرز هذه الفضيلة فقد لزمه أن يعدل
على أصدقائه وأهله وعشيرته ثم يستعمله في الأباعد وسائر الحيوان وإذ قد صح
ذلك وظهر ظهورا حسيا فقد ظهر بظهوره إن شر الناس من جار على نفسه ثم على
أصدقائه وعشيرته ثم على كافة الناس والحيوان لأن العلم بأحد الضدين هو
العلم بالضد الآخر. فخير الناس العادل وشرهم الجائر كما تبين ذلك. وقد
ادعى قوم أن نظام أمر الموجودات كلها وصلاح أحوالها معلق بالمحبة وقالوا
أن الإنسان إنما اضطر إلى اقتناء هذه الفضيلة أعني الهيئة التي تصدر عنها
العدالة عند تعاطي المعاملات لما فاته شرف المحبة. ولو كان المتعاملون
أحباء لتناصفوا ولم يقع بينهم خلاف. وذلك أن الصديق يحب صديقه ويريد له ما
يريد لنفسه ولا تتم الثقة والتعاضد والتوازر الأبين المتحابين.
وإذا
تعاضدوا وجمعتهم المحبة وصلوا إلى جميع المحبوبات ولم تتعذر عليهم المطالب
وإن كانت صعبة شديدة. وحيئنذ ينشئون الآراء الصائبة وتتعاون العقول على
استخراج الغوامض من التدابير القويمة ويتقوون على نيل الخيرات كلها
بالتعاضد.
وهؤلاء القوم إنما نظروا إلى فضيلة التأحد التي تحصل بين
الكثرة ولمعرى انها اشرف غايات أهل المدينة. وذلك أنهم إذا تحابوا تواصلوا
وأراد كل واحد منهم لصاحبه مثل ما يريده لنفسه فتصير القوى الكثيرة واحدة
ولم يتعذر على أحد منهم رأى صحيح ولا عمل صواب ويكون مثلهم في جميع ما
يحاولونه مثل من يريد تحريك ثقل عظيم بنفسه فلا يطيق ذلك.
فإن استعان
بقوة غيره حركه. ومدبر المدينة إنما يقصد بجميع تدابيره إيقاع المودات بين
أهلها وإذا تم له هذا خاصة فقد تمت له جميع الخيرات التي تتعذر عليه وحده
على أفراد أهل مدينته وحينئذ يغلب أقرانه ويعمر بلدانه ويعيش وهو ورعيته
مغبوطين. ولكن هذا التأحد المطلوب بهذهالمحبة المرغوب فيهما لا يتم إلا
بالآراء الصحيحة التي يرجى الإتفاق من العقول السليمة عليها والإعتقادات
القوية التي لا تحصل إلا بالديانات التي يقصد بها وجه الله عز وجل وأصناف
المحبات كثيرة وإن كانت ترتقي كلها إلى وجه واحد وسنقول فيها بمعونة الله
فيما يتلو هذه المقالة إن شاء الله.
؟المقالة الخامسة (التعاون
والإتحاد) قد سبق القول في حاجة بعض الناس إلى بعض وتبين أن كل واحد منهم
يجد تمامه عند صاحبه وأن الضرورة داعية إلى استعانة بعضهم ببعض لأن الناس
مطبوعون على النقصانات ومضطرون إلى تماماتها ولا سبيل فالحاجة صادقة
والضرورة داعية إلى حال تجمع وتؤلف بين أشتات الأشخاص ليصيروا بالاتفاق
والإئتلاف كالشخص الواحد الذي تجتمع أعضاؤه كلها على الفعل الواحد النافع
له.
؟المحبة وللمحبة أنواع وأسبابها تكون بعدد أنواعها. فأحد أنواعها
ما ينعقد سريعا وينحل سريعا. والثاني ما ينعقد سريعا وينحل بطيئا. والثالث
ما ينعقد بطيئا وينحل سريعا. والرابع ما ينعقد بطيئا وينحل بطيئا. وإنما
انقسمت إلى هذه الأنواع فقد لأن مقاصد الناس في مطالبهم وسيرهم ثلاثة
ويتركب بينها رابع وهي اللذة والخير والمنافع والمتركب منها.
وإذا
كانت هذه غايات الناس في مقاصدهم فلا محالة أنها أسباب المحبة من عاون
عليها وصار سببا للوصول إليها فقد أفلح: فأما المحبة التي يكون سببها
اللذة فهي التي تنعقد سريعا وتنحل سريعا. وذلك أن اللذة سريعة التغير كما
شرحنا أمرها فيما نقدم وأما المحبة التي سببها الخير فهي التي تنعقد سريعا
وتنحل بطيئا. وأما المحبة التي سببها المنافع فهي التي تنعقد بطيئا وتنحل
سريعا. وأما التي تتركب من هذه إذا كان فيها لأنها تكون بإرادة وروية
وتكون فبها مجازاة ومكافأة.
فأما التي تكون بين الحيوانات غير الناطقة
فالأحرى بها أن تسمى ألفا وتقع بين الأشكال منها خاصة. وأما التي لا نفوس
لها من الأحجار وأمثالها فليس يوجد فيها إلا الميل الطبيعي إلى مراكزها
التي تخصها. وقد يوجد أيضا بينها منافرة ومشاكلة بحسب أمزجتها الحادثة
فيها من عناصرها الأولى وهذه الأمزجة كثيرة وإذا وقع منها شيء يتناسب نسبة
تأليفية او عددية أو مساحية حدثت بينها ضروب من المشاكلة. وإذا كان أضداد
هذه النسب حدثت بينها منافرة وتحدث لها أشياء تسمى خواص وهي أفعال بديعة
وهي التي تسمى أسرار الطبائع ولا سيما في النسب التأليفية فإنها أشرف
النسب بعد نسبة المساواة ولها أضداد أعني هذه النسب. وهي مبينة مشروحة في
صناعة الإرتماطيقي ثم في صناعة التأليف. وأما الأمزجة التي بحسب هذه النسب
فهي خفية عنا وعسرة المرام وقد ادعة قوم الوصول إليها. وليست تكون هذه
الأفعال والخواص التي تحدث بين الأمزجة من النسب المذكورة موجودة في
العناصر أنفسها والكلام فيها خارج عن غرضنا. وإنما ذكرناها هنا لأنها تشبه
المشاكلات والمنافرات التي بين الحيوان في الظاهر والنسبة التي تحدث بين
الناس بالإراة وهي التي تتكلم فيها ويقع فيها مكافأة ومجازاة.
؟
الصداقة
الصداقة نوع من المحبة إلا أنها أخص منها وهي المودة بعينها وليس يمكن أن تقع بين جماعة كثيرين كما تقع المحبة. وأما العشق فهو إفراط في المحبة وهو أخص من المودة وذلك أنه لا يمكن أن يقع إلا بين اثنين فقط ولا يقع في النافع ولا في المركب من النافع وغيره وإنما يع لمحب اللذة بإفراد ولمحب الخير بافراط وأحدهما مذموم والآخر محمود، فالصداقة بين الأحداث ومن كان في مثل طباعهم إنما تحدث لأجل اللذة فهم يتصادقون سريعا ويتقاطعون سريعا وربما اتفق ذلك بينهم في الزمان القليل مرارا كثيرة، وربما بقيت بقدر ثقتهم ببقاء اللذة ومعاودتها حالا بعد حال. فإذا انقطعت هذه الثقة بمعلودتها انقطعت الصداقة بالوقت وفي الحال. والصداقة من المشائخ ومن كان في مثل طباعهم إنما نقع لمكان المنفعة فهم يتصادقون بسببها فإذا كانت المنافع مشتركة بينهم وهي في الأكثر طويلة المدة كانت الصداقة باقية. فحين تنقطع علاقة المنفعة بينهم وينقطع رجاؤهم من المنفعة المشتركة تنقطع موداتهم. والصداقة بين الأخيار تكون لأجل الخير وسببها هو الخير.ولما كان الخير شيئا غير متغير الذات صارت مودات أصحابه باقية غير متغيرة. وأيضا لما كان الإنسان مركبا من طبائع متضادة صار ميل كل واحد منها يخالف ميل الآخر. فاللذة التي توافق إحداها تخالف لذة الأخرى التي تضادها فلا تخلص له لذة غير مشوبة بأذى. ولما كان فيه أيضا جوهر آخر بسيط إلهي غير مخالط لشيء من الطبائع الأخرى صارت له لذة غير مشابهة لشيء من تلك اللذات وذلك أنها بسيطة أيضا. والمحبة التي سببها هذه اللذة هي التي تفرط حتى تصير عشقا تاما خالصا شبيها بالوله. وهي المحبة الإلهية الموصوفة التي يدعيها بعض المتألهين وهي التي يقول فيها أرسطوطاليس حكاية عن ابرفليطس: " إن الأشياء المختلفة لا تتشاكل ولا يكون منها تأليف جيد.
وأما الأشياء المتشاكلة وهي التي يسر بعضها ببعض ويشتاق بعضها إلى بعض فأقول عنها. إن الجواهر البسيطة إذا تشاكلت واشتاق بعضها إلى بعض تألفت وإذا تألفت صارت شيئا واحدا لا غيرية بينها إذ الغيرية إنما تحدث من جهة الهيولي. وأما الأشياء ذوات الهيولي وهي الإجرام فإنها وإن اشتاقت بنوع من الشوق إلى التألف فإنها لا تتحد ولا يمكن ذلك فيها. وذلك أنها تلتقي بنهاياتها وسطوحها دون ذواتها وهذا الإلتقاء سريع الإنفصال إذ كان التأحد فيه ممتنعا. وإنما تتأحد بنحو استطاعتها أعني ملاقاة سطوحها.
فإذا الجوهر الإلهي الذي في الإنسان إذا صفا من كدورته
التي حصلت فيه من ملابسة الطبيعة ولم تجذبه أنواع الشهورات وأصناف محبات
الكرامات اشتاف إلى شبيهه ورأى بعين عقله الخير الأول المحض الذي لا تشوبه
مادة فأسرع إليه وحينئذ يفيض نور ذلك الخير الأول عليه فيلتذ به لذة لا
تشبهها لذة ويصير إلى معنى الإتحاد الذي وصفناه استعمل الطبيعة البدنية أم
لم يستعملها. إلا أنه بعد مفارقته الطبيعة بالكلية أحق بهذه المرتبة
العالية لأنه ليس يصفو الصفاء التام إلا بعد مفارقته الحياة الدنيوية.
ومن
فضائل هذه المحبة الإلهية أنها لا تقبل النقصان ولا تقدع فيها السعاية ولا
يعترض عليها الملك ولا تكون إلا بين الأخيار فقط. وأما المحبات التي تكون
بسبب المنفعة واللذة فقد تكون بين الأشرار وبين الأخيار والأشرار. إلا
أنها تنقضي وتنحل مع تقضي المنافع واللذائذ لأنها عرضية وكثيرا ما تحدث
بالإجتماعات في المواضع الغريبة. إلا انها تزول بزوال المواضع كالسفينة
وما جرى مجراها.
والسبب في هذه المحبة الأنس وذلك أن الإنسان آنس
بالطبع وليس بوحشي ولا نفور ومنه اشتق إسم الإنسان في اللغة العربية وقد
تبين ذلك في صناعة النحو وليس كما قال الشاعر:
سميت إنسانا لأنك ناس
فإن
هذا الشاعر ظن أن الإنسان مشتق من النسيان وهو غلط منه. وينبغي ان يعلم أن
هذا الأنس الطبيعي في الإنسان هو الذي ينبغي أن نحرص عليه ونكتسبه مع
أبناء جنسنا حتى لا يفوتنا بجهدنا واستطاعتنا فإنه مبدأ المحبات كلها.
الشريعة تدعو إلى الأنس والمحبة
وإنما وضع للناس بالشريعة وبالعادة الجميلة إتخاذ الدعوات والإجتماع في المآدب ليحصل لهم هذا الأنس. والشريعة إنما أوجبت على الناس أن يجتمعوا في مساجدهم كل يوم خمس مرات وفضلت صلاة الجماعة على صلاة الآحاد ليحصل لهم هذا الأنس الطبيعي الذي هو فيهم بالقوة حتى يخرج إلى الفعل ثم يتأكد بالإعتقادات الصحيحة التي تجمعهم.وهذا الإجتماع في كل يوم ليس يتعذر على أهل كل محلة وسكة. والدليل على أن غرض صاحب الشريعة ما ذكرناه أنه أوجب على أهل المدينة بأسرهم أن يجتمعوا في كل أسبوع يوما بعينه في مسجد يسعهم ليجتمع أيضا شمل أهل المحال والسكك في كل أسبوع كما اجتمع شمل أهل الدور والمنازل في كل يوم. ثم أوجب أيضا أن يجتمع أهل المدينة مع أهل القرى والرساتيق المتقاربين في كل سنة مرتين في مصلى بارزين مصحرين ليسعهم المكان ويتجدد الأنس بين كافتهم وتشملهم المحبة الناظمة لهم.
ثم اوجب بعد ذلك أن يجتمعوا في العمر كله مرة واحدة في الموضع المقدس بمكة ولم يعين من العمر وقت مخصوص ليتسع لهم الزمان وليجتمع أهل المدن المتباعدة كما اجتمع أهل المدينة الواحدة ويصير حالهم في الأنس والمحبة وشمول الخير والسعادة كحال المجتمعين في كل سنة وفي كل اسبوع وفي كل يوم فيجتمعوا بذلك إلى الأنس الطبيعي وإلى الخيرات المشتركة وتتجدد بينهم محبة الشريعة وليكبروا الله على ما هداهم ويغتبطوا بالدين القويم القيم الذي ألفهم على تقوى الله وطاعته.
الخليفة يحرس الدينوالقائم بحفظ هذه السنة وغيرها من وظائف الشرع حتى لا تزول عن أوضاعها هوالإمام وصناعته هي صناعة الملك. والأوائل لا يسمون بالملك إلا من حرس الدين وقام بحفظ مراتبه وأوامره وزواجره. وأما من أعرض عن ذلك فيسمونه متغلبا ولا يؤهلونه لإسم الملك وذلك أن الدين هو وضع إليه يسوق الناس باختيارهم إلى السعادة القصوى.
والملك هو حارس هذا الوضع الإلهي حافظ على الناس ما ا×ذوا به. وقد قال حكيم الفرس وملكهم ازدشير: " إن الدين والملك إخوان توأمان لايتم أحدهما إلا بالآخر " فالدين أس والملك حارس. وكل مالا أس له فمهدوم. وكل مالا حارس له فضائع. ولذلك حكمنا على الحارس الذي نصب للدين أن يتيقظ في موضعه ويحكم صناعته ولا يباشر أمره يالهوينا ولا يشتغل بلذة تخصه ولا يطلب الكرامة والغلبة إلا من وجهها. فإنه متى أغفل شيئا من حدوده دخل عليه من هنالك الخلل والوهن.
وحيئنذ تتبدل أوضاع الدين ويجد الناس رخصة في شهواتهم ويكثر من
يساعدهم على ذلك فتنقلب هيئة السعادة إلى ضدها ويحدث بينهم الإختلاف
والتباغض فأداهم ذلك إلى الشتات والفرقة وبطل الفرض الشريف وانتقض النظام
الذي طلبه صاحب الشرع بالأوضاع الإلهية فاحتيج حينئذ إلى تجديد الأمر
واستئناف التدبير وطلب الإمام الحق والملك العدل ونعود إلى ذكر أجناس
المحبات وأسبابها فنقول:
أجناس المحبات وأسبابها
إن هذه الأسباب كلها ماخلا المحبة الإلهية إذا كانت مشتركة بين المتحابين وكانت واحدة بعينها جاز في الشيئين أن ينعقدا معا وينحلا معا وجاز أيضا أن يبقى أحدهما وينحل الآخر.مثال ذلك أن اللذات المشتركة بين الرجل والمرأة هي سبب للمحبة بينهما فقد يجوز أن تجتمع المحبات لأن السبب واحد وهي اللذة. وقد يجوز أن تنقطع إحداهما وتبقى الأخرى وذلك أن اللذة تتغير ولا تكاد تثبت كما تقم وصفها. فقد يجوز أن يتغير سبب إحدى المحبتين ويثبت الآخر. وايضا فإن بين الرجل وبين زوجته خيرات مشتركة ومنافع مختلفة وهما يتعاونان عليها أعني الخيرات الخارجة عنها وهي الأسباب التي تعمر بها المنازل.
فالمرأة تنتظر من زوجها تلك الخيرات لأنه هو الذي يكتسبها ويحضرها. وأما الرجل فإنه ينتظر من زوجته ضبط تلك الخيرات لأنها هي التي تحفظها وتدبرها لتثمر ولا تضيع فمتى قصر أحدهما اختلفت المحبة وحدثت الشكايات ولا تزال كذلك إلى أن تتقطع أو تبقى مع الشكايات والملامة. وكذلك حال المنفعة المشتركة بين الناس إذا كانت واحدة بعينها.
وأما المحبات المختلفة التي أسبابها مختلفة فهي أولى بسرعة التحلل. ومثال ذلك أن تكون محبة أحد المتحابين لأجل المنفعة ومحبة الآخر لأجل اللذة كما يعرض ذلك للمعاشرين على أن أحدهما مغن والآخر مستمع فإن المغنى منهما يحب المستمع لأجل المنفعة والمستمع منهما يحب المغنى لأجل اللذة. وكما يعرض أيضا بين العاشق والمعشوق اللذين أحدهما يلتذ بالنظر والآخر ينتظر المنفعة وهذا الصنف من المحبة يعرض فيه أبدا التشكي والتظلم. وذلك أن طالب اللذة يتعجل مطلوبه وطالب المنفعة يتأخر عنه ولا يكاد يعتدل الأمر بينهما. لذلك ترى العاشق يشكو معشوقه ويتظلم منه وهو بالحقيقة ظالم ينبغي أن يشتكي لأنه يتعجل لذته بالنظر ولا يرى المكافأة بما يستحق صاحب.
والمحبة اللوامة كثيرة الأنواع غلا أن الأصل فيها ما ذكرت. ويوشك أن تكو المحبة بين الرئيس والمرؤوس والغنى والفقير تعرض لها الملامة والتوبيخ لأجل اختلاف الأسباب ولأن كل واحد ينتظر من المكافأة عند الآخر ما لا يجده عنده فيقع فساد في النيات بينهما ثم استبطاء ثم ملامات. ويزيل ذلك طلب العدالة ورضاء كل واحد بما يستحقه من الآخر وبذل كل واحد للآخر العدل المبسوط بينهما.
والمماليك خاصة لا يرضيهم من مواليهم إلا الزيادة الكثيرة في الإستحقاق وكذلك الموالي يستبطئون العبيد في الخمدمة والشفقة والنصيحة وفي جميع ذلك يقع اللوم وفساد الضمير.
فهذه المحبة اللوامة لا يكاد يخلوا الإنسان منها إلا على شريطة العدل وطلب الوسط من الإستحقاق والرضا به وهو صعب.
محبة الأخياروأما محبة الأخيار بعضهم بعضا فإنها تكون لا للذة خارجة ولا لمنفعة بل للمناسبة الجوهرية بينهما وهي قصد الخير والتماس الفضيلة. فإذا أحب أحدهم للمناسبة الجوهرية بينهما وهي قصد الخير والتماس الفضيلة. فإذا أحب أحدهم الآخر لهذه المناسبة لم تكن بينهم مخالفة ولا منازعة ونصح بعضهم بعضا وتلاقوا بالعدالة والتساوي في إرادة الخير وهذا التساوي في النصيحة وإرادة الخير هو الذي يوحد كثرتهم. ولهذا حد الصديق بأنه آخر هو أنت إلا أنه غيرك بالشخص ولهذا صار عزيز الوجود ولم يوثق بصداقة الأحداث والعوام ومن ليس بحكيم لأن هؤلاء يحبون ويصادقون لأحل اللذة والمنفعة ولا يعرفون الخير بالحقيقة وأغراضهم غير صحيحة، وأما للسلاطين فإنهم يظهرون الصداقة على أنهم متفضلون ومحسنون إلى من يصادقهم فلا يدخلون تحت الحد الذي ذكرناه وفي صداقتهم زيادة ونقصان المساواة عزيزة الوجود عندهم.
وكذلك محبة الوالد
للولد والولد للوالد فإن أنواع هذه المحبة مختلفة وأسبابها أيضا مختلفة
كما قلنا إلا أن محبة الوالد للولد والولد للوالد وإن كان بينهما اختلاف
ما من وجه فإن بينهما إتفاقا ذاتيا.
وأعني بالذاتي ههنا إن الوالد يرى
في ولده أنه هو هو وأنه نسخ صورته التي تخصه من الإنسانية في شخص ولده
نسخا طبيعيا ونقل ذاته إلى ذاته نقلا حقيقيا. وحق له أن يرى ذلك لأن
التدبير الإلهي بالسياسة الطبيعية التي هي سياسته عز وجل هو الذي عاون
الإنسان على إنشاء الولد وجعله السبب الثاني في إيجاده ونقل صورته
الإنسانية إليه.
ولذلك يحب الوالد لولده جميع ما يحبه لنفسه ويسعى في
تأديبه وتكميله بكل ما فاته في نفسه طول عمره. ولا يشق عليه أن يقال له
ولدك أفضل منك لأنه يرى أنه هو هو. وكما أن الإنسان إذا تزايد في نفسه
حالا فحالا وترقى في الفضيلة درجة فدرجة لا يشق عليه أن يقال له إنك الآن
أفضل مما كنت بل يسره ذلك كذلك تكون حاله إذا قيل له في ولده مثل ذلك. ثم
تفضل أيضا محبة الوالد على محبة الولد بأنه الفاعل له وبأنه يعرفه منذ أول
تكوينه ويستبشر به وهو جنين ثم تزداد محبته له مع التربية والنشأة ويتأكد
سروره به وتأميله له. ويحدث له اليقين بأنه باق به صورة وأن فنى بجسمه
مادة وهذه المعاني الجليلة عند أهل العلم تتراءى للعوام كأنها من وراء ستر.
وأما
محبة الولد للوالد فإنها تنقص عن هذه الرتبة بأن الولد مفعول وبأنه لا
يعرف ذاته ولا فاعل ذاته إلا بعد زمان طويل وبعد أن يستثبت أباه حسا
وينتفع به دهرا ثم يعقل بعد ذلك أمره بالصحة وعلى مقدار عقله واستبصاره في
الأمور يكون تعظيمه لوالديه ومحبه لهما ولهذه العلة وصى الله عز وجل الولد
بوالده ولم يوص الوالد بولده. وأما محبة الأخوة بعضهم لبعض فلأن سبب
تكوينهم ونشؤهم واحد بعينه.
نسبة الملك إلى رعيته
ويجب أن تكون نسبة الملك إلى رعيته نسبة أبوية ونسبة رعيته إليه نسبة بنوية ونسبة الرعية بعضهم إلى بعض نسبة أخوية حتى تكون السياسات محفوظة على شرائطها الصحيحة. وذلك أن مراعاة الملك لرعيته هي مراعاة الأب لأولاده ومعاملته إياهم تلكالمعاملة. وقد كنا أشرنا إلى ذلك وسنزيده بيانا إذا صرنا إلى ذكر سياسة الملك في موضع آخر. وعنايته برعيته يجب أن تكون مثل عناية الأب بأولاده شفقة وتحننا وتعهدا وتعطفا خلافة لصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم بل لمشرع الشريعة تعالى ذكره في الرأفة والرحمة وطلب المصالح لهم ودفع المكاره عنهم وحفظ النظام فيهم وبالجملة في كل ما يجلب الخير ويمنع الشر. فإنه عند ذلك تحبه رعيته محبة الأولاد للأب الشفيق وتحدث بينهما تلك النسبة وإنما تختلف هذه المحبات بالتفاضل الذي يكون بعظم المنافع.فيجب أن يكرم الأب كرامة أبوية. ويكرم السلطان كرامة سلطانية،ويكرم الناس بعضهم بعضا كرامة أخوية ولكل مرتبة من هذه استئهال خاص بها واستحقاب واجب لها. فإذا لم يحفظ بالعدالة زاد ونقص وعرض لها الفساد وانتقلت الرياسات وانعكست الأمور فيعترض لرياسة الملك أن تنتقل إلى رياسة التغلب ويتبع ذلك أن تنتقل محبة الرعية إلى البغض له ويعرض لرياسات من دونه مثل ذلك. فتصير محبة الأخيار إلى تباغض الأشرار وتعود الألفة نفارا والتواد نفاقا ويطلب كل واحد لنفسه ما يظنه خيرا له وأن أضر بغيره وتبطل الصداقات والخير المشترك بين الناس ويؤول الأمر إلى الهرج الذي هو ضد النظام الذي رتبه الله لخلقه ورسمه بالشريعة وأوجبه بالحكمة البالغة.
المحبة التي لا تطرأ عليها الآفات
وأماالمحبة
التي لا تشوبها الإنفعالات ولا تطرأ عليها الآفات وهي محبة العبد لخالقه
عز وجل فإنها إنما تخلص للعالم العرباني وحده خاصة ولا سبيل لغيره إليها
إلا بالدعوى الكاذبة. وكيف يجد الإنسان السبيل غلىمحبة من لا يعرفه ولا
يعرف ضروب إنعامه الدارة عليه ووجوه إحسانه المتصلة به في بدنه وفنسه
اللهم إلا أن يتصور في نفسه صنما ويظنه الخالق عزوجل فيحبه ويعبده فإن
اكثر الناس كما قال تعالى: (وَما يُؤمِنُ أَكثَرُهم بِاللهِ إِلا وَهُم
مُشرِكون) ولعمري أن العامة تدعى المعرفة والمحبة وهم يتصورون شخصا وشبحا
فتكون عبادتهم له دون الله وهذا هو الضلال البعيد. ومدعو هذه المحبة
كثيرون جدا والمحقون منهم قليلون حداا بل هم أقل من القليل. وهذه المحبة
لا محالة تتصل بها الطاعة والتعظيم ويتلوها ويقرب منها محبة الوالدين
وإكرامهما وطاعتهما. وليس يرتقي إلى مرتبتهما شيء من المحبات الأخر إلا
محبة الحكماء وطاعتهما. وليس يرتقي إلى مرتبتهما شيء من المحبات الأخر إلا
محبة المحكماء عند تلامذتهم فإنها متوسطة بين المحبة الأولى والمحبة
الثانية.
وذلك أن المحبة الأولى لا يبلغها شيء من المحبات كما أن
أسبابها لا يبلغها شيء من الأسباب والنعم التي تأتي من قبلها لا يشبهها
شيء من النعم. وأماالمحبة الثانية فهي تتلوها لأن سببها هو السبب الثاني
في وجودنا الحسي أعني أبداننا وتكويننا.
وأما محبة الحكماء فهي أشرف
وأكرم من محبة الوالدين لأجل أن تربيتهم هي لنفوسنا وهم الأسباب في وجودنا
الحقيقي وبهم وصولنا إلى السعادة التامة التي نلنا بها اللقاء الأبدي
والنعيم السرمدي في جوار رب العالمين. فبحسب فضل إنعامهم علينا وبقدر فضل
النفوس على الأبدان تجب حقوقهم وتلزم طاعتهم ومحبتهم وليس يبلغ أحد جزاء
ولا مكافأة الأول ولا ما يستأهله الثاني أعني الوالدين وإن هو اجتهد وبالغ
ولا يؤدي حقوقهما أبدا وإن خدم بأقصى طاقته وغاية وسعه، وأما محبة طلب
الحكمة للحكيم والتلميذ الصالح للمعلم الخير فإنها من جنس المحبة الأولى
وفي طريقها. وذلك لأجل الخير العظيم الذي يشرف عليه ويصل إليه وللرجاء
الكريم الذي لا يتحقق إلا بعنايته ولا يتم إلا بمطالعته. ولأنه والدروحاني
ورب بشرى وإحسانه إحسان إليه ذلك أنه يربيه بالفضيلة التامة ويغذوه
بالحكمة البالغة ويسوقه إلى الحياة الأبدية والنعيم السرمدي. وإذا كان هو
السبب في كل وجودنا العقلي وهو المربي لنفوسنا الروحانية فبحسب فضل النفس
على البدن يجب أن يفضل المنعم بذاك وبقدر فضلها على البدن يكون فضل
التربية على التربية فيحق أن يحب التلميذ معلم الحكمة محبة خالصة شبيهة
بالمحبة الأولى. ولذلك قلنا أن هذه المحبة من جنس المحبة الأولى والطاعة
له من جنس تلك الطاعة وكذلك تعظيمه له وإجلاله إياه. ثم لما كان سبب هاتين
النعمتين ومعرضنا لهما وسائقنا إليهما وإلىجميع النعم هو السبب الأول الذي
هو سبب الخيرات كلها قربت منا أوبعدت عنا عرفناها أو لم نعرفها وجب أن
تكون محبتنا لهفي أعلى مراتب المحبات وكذلك طاعتنا له وتمجيدنا إياه. ويجب
على من بلغ هذه المنزلة من الأخلاق أنيعرف مراتب المحبات وما يستحقه كل
واحد من صاحبه حتى لا يبذل كرامة الوالد للرئيس الأجنبي ولا كرامة الصديق
للسلطان ولا كرامة الولد للعثير ولا كرامة الأب للإبن.
فإن لكل واحد من
هؤلاء وأشباههم صنفا من الكرامة وحقا من الجزاء ليس للآخر ومتى خلط فيه
اضطرب وفسد وحدثت الملامات وإذا وفى كل واحد منهم حقه وقسطه من المحبة
والخدمة والنصيحة كان عادلا وأوجبت له محبته وعدالته فيها محبته لصاحبه
ومعامله. وكذلك يجب أن يجري الأمر في مؤانسة الأصحاب والخلطاء والمعاشرين
من توفية حقوقهم وإعطائهم ماهو خاص بهم. ومن غش المحبة والصداقة كان أسوأ
حالا ممن غش الدرهم والدينار.
فإن الحيكم ذكر أن المحبة المغشوشة
تنحل سريعا وتفسد وشيكا كما أن الدرهم والدينار إذا كانا مغشوشين فسدا
سريعا وهذا واجب في جميع أنواع المحبات. ولذلك يتعاطى العاقل أبدا أنمطاء
واحدا ويلزم مذهبا واحدا في إرادة الخير ويفعل جميع ما يفعله من أجل ذاته
ويرى خيره عند غيره كما يراه عند نفسه. وأما صديقه فقد قلنا أنه هو هو إلا
أنه غير بالشخص إما سائر مخالطيه ومعارفه فإنه يسلك بهم مسلك أصدقائه كأنه
مجتهد في أن يبلغ بهم وفيهم منازل الأصدقاء بالحقيقة وأن كان لا يمكن ذلك
في جميعهم. فهذه سيرة الخير في نفسه وفي رؤسائه وأهله وعشيرته وأصدقائه
وسلطانه.
الشرير
وأما الشرير فإنه يهرب من هذه السيرة وينقر منها لرداءة الهيئة التي حصلت له ولمحبة البطالة والتكاسل عن معرفة الخير والتمييز بينه وبين الشر وبين ماهو مظنون عنده خيرا وليس بخير.ومن كان على هذه الحالة من الشر ورداءة الهيئة كانت أفعاله كلها رديئة.
ومن كانت ذاته رديئة هرب من ذاته لأجل أن الرداءة مهووب منها واضطر إلى صحبة قوم يناسبونه ليفنى عمره معهم ويشتغل بهم عن ذاته وما يجده فيها من الإضطراب والقلق. ذلك أن هؤلاء الأشرار إذا خلوا بأنفسهم تذكروا أفعالهم الرديئة وهاجت بهم القوى المتضادة التي تدعوهم إلى إرتكاب الشرور المتضادة فيألمون من ذواتهم وتتشاغب نفوسهم كل الشغب وتجذبهم القوى التي فيهم وهي التي لم يروضوها بالأدب الحقيقي إلى جهات مختلفة من اللذات الرديئة وطلب الكرامات التي لا يستحقونها والشهوات الرديئة التي تهلكهم سريعا.
فإذا جذبتهم هذه القوى إلى جهات مختلفة أحدثت فيهم آلاما كثيرة لأنه لا يمكن أن يفرح ويحزن معاولا يرضى ويسخط في حال واحدة ولا يستطيع أن يؤلف بين الأضداد حتى تجتمع له فهومن شقائه يهرب من ذاته لأنها رديئة فاسدة متألمة كثيرة الشغب عليه ويلتمس لعشرته ومخالطة من هومثله وأسوأ حالا منه فيجد للوقت راحة به وسكونا إليه لأجل المشاكلة ثم يعود بعد قليل وبالا عليه وزيادة في خباله وفساده فيألم به ويهرب منه ليس له محب ولا ذاته ولا له نصيح ولا نفسه وليس يتحصل الأعلى الندامة ولا يرجع إلا إلى الشقوة.
الخير الفاضلوأما الرجل الخير الفاضل فإن سيرته جيدة محبوبة فهو يحب ذاته وأفعاله ويسر بنفسه ويسر به أيضا غيره ويختار كل إنسان مواصلته ومصادقته فهو صديق نفسه والناس أصدقاؤه وليس يضاده إلا الشرير فقط ويعرض لمن هذه سيرته أن يحسن إلىغيره بقصد وبغير قصد. وذلك أن أفعاله لذيذة محبوبوة واللذيذ المحبوب مختار فيكثر المقبلون عليه والمحتفون به والآخذون عنه.
وهذا هو الإحسان الذاتي الذي يبقى ولا ينقطع ويتزايد على الأيام ولا ينتقص.
وأما الإحسان العرضي الذي ليس بخلقي ولا هو سيرة لصاحبه فإنه ينقطع ويلحق فيه اللوم. والمحبة التي تعرض منه تلحق بالمحبات اللوامة.
ولذلك يوصي صاحبه بتربيته فيقال له تربية الصنعة أصعب من إبتدائها. والمحبة التي تحدث بين المحسن والمحسن إليه يكون فيها زيادة ونقصان أعني أن محبة المحسن للمحسن إليه أشد من محبة المحسن إليه للمحسن. واستدل أرسطوطاليس على ذلك بأن المقرض وصانع المعروف يهتم كل واحد منهما بمن أقرضه واصطنع المعروف عنده ويتعاهد أنهما ويحبان سلامتهما. أما المقرض فربما أحب سلامة المقترض لمكان الأخذ لا لمكان المحبة أعني أنه يدعو له بالسلامة والبقاء وسبوغ النعمة ليصل إلى حقهز وأما المقترض فليس يعني كبير عناية بالمقرضولا يدعو له بهذه الدعوات وأما مصطنع المعروف فإنه بالحق الواجب يود الذي اصطنع إليه معروفه وإن لم ينتظر منه منفعة. ذلك أن كل صانع فعل جيد محمود يحب مصنوعه فإذا كان مصنوعه مستقيما جيدا وجب أن يكون محبوبا في الغاية. فقد تبين أن محبة المحسن أشد من محبة المحسن إليه.
وأما المحسن إليه فشهوته للإحسان أشد وأزيد من شهوة المحسن. وايضا فإن المحبة المكتسبة بالإحسان المرباة على طول الزمان تجري مجرى القنيات التي يتعب بتحصيلها فإن ما يكتسب منها على سبيل التعب والنصب تكون المحبة له أشد والضن به أكثر. ومن وصل إلى المال بغير تعب لم يكترث به ولم يشح عليه وبذله في غير موضعه كما يفعل الوراث ومن يجري مجراهم.
وأما من وصل إليه بتعب وسافر في طلبه وشقى
بجمعه فإنه لا محالة يكون شديد الضن به والمحبة له. ولهذه العلة صارت الأم
أكثر محبة للولد من الأب ويعرض لها من الحنين والوله أضعاف ما يعرض للأب.
وبهذا
النوع من المحبة يحب الشاعر شعره ويعجب به أكثر من أعجاب غيره ولك فاعل
فعل يتعب به فهو يحب فعله. وأيضا فإن المنفعل لا يتعب كتعب الفاعل والآخذ
منفعل والمعطي فاعل فمن هذه الوجوه يتبين أن مصطنع المعروف يحب من أحسن
إليه حيا شديدا. ومن الناس من يصطنع المعروف لأجل الخير نفسه. ومنهم من
يصطنعه لأجل الذكر الجميل. ومنهم من يصطنعه رياء فقط. ومن البين أن أعلاهم
مرتبة من صنعه لذاته أعني لذات الخير. وصاحب هذه الرتبة لا يعرف الذكر
الجميل والثناء الباقي ومحبة من لم يصطنع المعروف عنده وإن لم يقصد ذلك
الفعل ولا بالنية.
ولما حكمنا فيما تقدم حكما مقبولا لا يرده أحد وهو
أن كل إنسان يجب نفسه وكانت هذه المحبة لا محالة تنقسم بالأقسام الثلاثة
التي ذكرناها أعني اللذة والمنافع والخير وجب من ذلك أن لا يوجد من لا
يميز بين هذه الأقسام حتى يعرف الأفضل ، فالأفضل منها فلا يدري كيف يحسن
إلى نفسه التي هي محبوبته فيقع في ضروب من الخطأ لجهله بالخير الحقيقي.
ولذلك
صار بعض الناس يختار لنفسه سيرة اللذة وبعضهم سيرة الكرامة والمنافع لأنهم
لا يعرفون ما هو أفضل منها. وأما من عرف سيرة الخير وعلو مرتبته فهو لا
محالة يختار لنفسه أفضل السير وأكرم الخيرات فلا يؤثر اللذات البهيمية ولا
اللذات الخارجة عن نفسه فإنها عرضية كلها ومستحيلة ومنحلة لكنه يختار لها
أتم الخيرات وأعلاها واعظمها وهو الخير الذي لها بالذات أعني الذي ليس
بخارج عنها وهو الذي ينسب إلى جزئه الإلهي ومن سار بهذه السيرة وأختارها
لنفسه فقد أحسن إليها وأنزلها في الشرف الأعلى وأهلّها لقبول الفيض الإلهي
واللذة الحقيقية التي لا تفارقه أبدا. وإذا كان بهذه الحال فهو لا محالة
يفعل سائر الخيرات الأخر وينفع غيره ببذل الأموال والسماحة بجمع ما يتشاح
الناس عليه ويخص أصدقاءه من ذلك بكل ما يضيق عنه ذرع أصحاب السير الباقية
فيصير معظما عند كل واحد ولا سيما عند صديقه. وقد بينا فيما تقدم ان
الإنسان مدني بالطبع وشرحنا ومن كان تمامه عند غيره فمن المحال أن يصل مع
الوحدة والتفرد إلى سعادته التامة.
؟الأصدقاء: فالسعيد إذا من اكتسب
الأصدقاء واجتهد في بذل الخيرات لهم ليكتسب بهم مالا يقدر أن يكتسبه لذاته
فيلتذ بهم أيام حياته ويلتذون أيضا به.
وقد شرحنا حال هذه اللذة وأنها
باقية إلهية غير منحلة ولا متغيرة وهؤلاء في جملة الناس قليلون جدا. وأما
أصحاب اللذات البهيمية والنافع فيها فكثيرون جدا وقد يكتفي من هؤلاء
بالقليل كالأبازير في الطعام وكالملح خاصة. وأما الصديق الأول الذي ذكرنا
وصفه فلا يمكن أن يكون كثيرا لعزته ولأنه محبوب بإفراط وإفراط المحبة لا
يصح ولا يتم إلا لواحد. وأما حسن العشرة وكرم اللقاء والسعي لكل أحد بسيرة
الصديق الحقيقي فمبذول لأجل طلب الفضيلة ولأنا قد قلنا فيما تقدم أن الرجل
الخير الفاضل يسلك في عشرة معارفه مسلك الصديق وإن لم تتم الصداقة
الحقيقية فيهم. وارسطوطاليس يقول: (إن الإنسان محتاج إلى الصديق عند حسن
الحال وعند سوؤ الحال. فعند سوء الحال يحتاج إلى معونة الأصقاء وعند حسن
الحال يحتاج إلى المؤانسة وإلى من يحسن إليه).
ولعمري ان الملك
العظيم يحتاج إلى من يصطنعه ويضع إحسانه عنده كما أن الفقير من الناس
يحتاج إلى صديق يصطنعه ويضع عنده المعروف. قال (ومن أجل فضيلة الصداقة
يشارك الناس بعضهم بعضا ويتعاشرون عشرة جميلة ويجتمعون في الرياضات والصيد
والدعوات،وأما سقراطيس فإنه قال بهذه الألفاظ: (إني لأكثر التعجب ممن يعلم
أولاده أخبار الملوك ووقع بعضهم ببعض وذكر الحروب والضغائن ومن انتقم أو
وثبت على صاحبه ولا يخطر ببالهم امر المودة وأحاديث الألفة وما يحصل من
لخيرات العامة لجميع الناس بالمحبة والأنس. وأنه لا يستطيع أحد من الناس
أن يعيش بغير المودة وإن مالت إليه الدنيا بجميع رغائبها. فإن ظن أحد أن
أمر المودة صغير فالصغير من ظن ذلك. وإن قدر أنه موجود ويسير الخطب يدرك
بالهوينا فما أصعبه وما أعسر وجود صداقة يوثق بها عند البلوى) ثم قال:
(لكني أعتقد وأقول أن قدر المودة وخطرها عندي أعظم من جميع ذهب كنوز قارون
ومن ذخائر الملوك ومن جميع ما يتنافس فيه أهل الأرض من الجواهر وماتحويه
الدنيا برا وبحرا ما يتقلبون فيه من سائر الأمتعة والأثاث.
ولا يعدل جميع ذلك ما اخترته لنفسي من فضيلة المودة. وذلك أن جميع ما أحصيته لا ينفع صاحبه إذا حلت به لوعة مصيبة في صديقه.
وافهم
من الصديق ههنا أنه آخر هو أنت سواء كان أخا من نسب أو غريبا أو ولدا أو
والدا ولا يقوم له جميع ما في الأرض مقام صديق يثق به في مهم يساعده عليه
سعادة عاجلة أو آجلة تتم له.
فطوبى لمن أوتي هذه النعمة العظيمة وهو
خلو من السلطان. وأعظم طوبى لمن أتيه في سلطان. ذلك أن من باشر أمور
الرعية وأراد أن يعرف أحوالهم وينظر في أمورهم حق النظر لن يكفيه أذنان
ولا عينان ولا قلبد واحد فإن وجد إخوانا ذوي ثقة وجد بهم عيونا وآذانا
وقلوبا كأنها بأجمعها له فقربت عليه أطرافه واطلع من أدنى أمره على أقصاه
ورأى الغائب بصورة الشاهد. فأنى توجد هذه الفضيلة إلا عند الصديق وكيف
يطمع فيها عند غير الرفيق الشفيق؟) ؟كيف يختار الصديق وإذ قد عرفنا هذه
النعمة الجليلة فيجب علينا أن ننظر كيف نقتنيها ومن أين نطلبها وإذا حصلت
لنا كيف نحتفظ بها لئلا يصيبنا فيها ما أصاب الرجل الذي ضرب به المثل حين
طلب شاة سمينة فوجدها وارمة فاغتر بها وظن الورم سمنا فأخذه الشاعر فقال:
أعيذها نظرات صادقة ... ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم
لا
سيما وقد علمنا أن الإنسان من بين الحيوان يتصنع حتى يظهر للناس منه مالا
حقيقة له فيبذل ماله وهو بخيل ليقال هو جواد ويقدم في بعض المواطن على بعض
المخاوف ليقال هو شجاع.
وكذلك يكون حال من لا يعرف الحشائش والنبات
فإنها تشتبه في عينه حتى ربما تناول منها شيئا وهو يظنه حلو فإذا طعمه
وجده مرا وربما ظنه غذاء فيكون سما. فينبغي لنا أننحذر ركوب لخطر في تحصيل
هذه النعمة الجليلة حتى لا نقع في مودة المموهين الخداعين الذين يتصورون
لنا بصورة الفضلاء الأخيار. فإذا حصلونا في شباكهم افترسونا كما تفترس
السباع أكيلتها. والطرق إلى السلامة من هذا الخطر بحسب ما أخذناه عن
سقراطيس إذا أردنا أن نستفيد صديقا أن نسأل عنه كيف كان في صباه مع والديه
ومع إخواته وعشيرته فإن كان صالحا معهم فارج الصلاح منه وإلا فابعد منه
وإياك وإياه. قال: (ثم إعرف بعد ذلك سيرته مع أصدقائه قبلك فأضفها إلى
سيرته مع إخوته وآبائه. ثم تتبع أمره في شكر من يجب عليه شكره أو كفره
النعمة. ولست أعني بالشكر المكافأة التي ربما عجز عنها بالفعل ولكن ربما
عطل نيته في الشكر فلا يكافىء بما يستطيع وبما يقدر عليه ويغتنم الجميل
الذي يسدى إليه ويراه حقا له أو يتكاسل عن شكره باللسان. وليس أحد يتعذر
عليه نشر النعمة التي تتولاه والثناء على صاحبها والإعتداد له بها. وليس
شيء أشد إحتياجا للنقم من الكفر وحسبك ما أعده الله لكافر نعمته من النقم
مع تعاليه عن الإستضرار بالكفر. ولا شيء أجلب للنعمة ولا أشد تثبيتا لها
من الشكر وحسبك ما وعد الله به الشاكرين مع إستغنائه عن الشكر. فتعرف هذا
الخلق ممن تريد مؤاخاته واحذر أن تبتلي بالكفر للنعم ولا تكن بالمستحقر
لأيادي الإخوان وإحسان السلطان.
ثم انظر إلى ميله إلى الراحات
وتباطئه عن الحركة التي فيها أدنى نصب. فإن هذا خلق ردىء ويتبعه الميل إلى
اللذات فيكون سببا للتقاعد عما يجب عليه من الحقوق.
ثم انظر نظرا شافيا
في محبته للذهب والفضة وإستهانته بجمعهما وحرصه عليهما فإن كثيرا من
المتعاشرين يتظاهرون بالمحبة ويتهادون ويتناصحون فإذا وقعت بينهم معاملة
في هذين الحجرين هر بعضهم على بعض هرير الكلاب وخرجوا إلى ضروب العداوة.
ثم انظر في محبته للرئاسة والتفريط فإن من أحب الغلبة والترؤس وأن يفرط لا
ينصفك في المودة ولا يرضى منك بمثل ما يعطيك ويحمله الخيلاء والتيه على
الإستهانة بأصدقائه وطلب الترفع عليهم ولا تتم مع ذلك مودة ولا غبطة ولا
بد من أن تؤول الحال بينهم إلى العداوة والأحقاد والأضغان الكثيرة. ثم
انظر هل هو ممن يستهزىء بالغناء واللحون وضروب اللهو واللعب وسماع المجون
والمضاحيك فإن كان كذلك فما أشغله عن مساعدات إخوانه ومواساتهم وما أشد
هربه عن مكافأة بإحسان وإحتمال النصب ودخول تحت جميل. فإن وجدته بريئا من
هذه الخلال فلتحتفظ عليه ولترغب فيه ولتكتف بواحد إن وجد فإن الكمال عزيز.
وأيضا
فإن من كثرت أصدقاؤه لم يف بحقوقهم واضطر إلى الأغضاء عن بعض ما يجب عليه
والتقصير في بعضه وربما ترادفت عليه أحوال متضادة أعني أن تدعوه مساعدة
صديق إلى أن يسر بسروره ومساعدة آخر أن يغتم بغمه وأن يسعى بسعي واحد
ويقعد بقعود آخر مع أحوال تشبه هذه كثيرة مختلفة. ولا ينبغي أن يحملك ما
حضضتك عليه من طلب الفضائل ممن تصادقه على تتبع صغار عيوبه فتصير بذلك إلى
أن لا يسلم لك أحد فتبقى خلوا من الصديق. بل يجب أن تغض عن المعايب
اليسيرة التي لا يسلم من مثلها البشر وتنظر ما تجده في نفسك من عيب فتحتمل
مثله من غيرك. واحذر عداوة من صادقته أو خالته أو خالطته مخالطة الصديق
واسمع قول الشاعر:
عدوك من صديقك مستفاد ... فلا تستكثرن من الصحاب
فإن الداء أكثر ما تراه ... يكون من الطعام أو الشراب
؟؟آداب
الصداقة لذلك يجب عليك متى حصل لك صديق أن تكثر مراعاته وتبالغ في تفقده
ولا تستهين باليسير من حقه عند مهم يعرض له أو حادث يحدث به.
فأما في
أوقات الرخاء فينبغي أن تلقاه بالوجه الطلق والخلق الرحب وأن تظهر له في
عينك وحركاتك وفي هشاشتك وارتياحك عند مشاهدته إياك ما يزداد به في كل يوم
وكل حال ثقة بمودتك وسكونا إليك ويرى السرور في جميع أعضائك التي يظهر
السرور فيها إذا لقيك. فإن التحفي الشديد عن طلعة الصديق لا يخفى وسرور
الشكل بالشك أمر غير مشكل. ثم ينبغي أن تفعل مثل ذلك بمن تعلم أنه يؤثره
ويحبه من صديق أو ولد أو تابع أو حاشية وتثنى عليهم من غير إسراف يخرج بك
إلى الملق الذي يمقتك عليه ويظهر لك منك تكلف فيه. وإنما يتم لك ذلك إذا
توخيت الصدق في كل ما تثنى به عليه. والزم هذه الطريقة حتى لا يقع منك
توان فيها بوجه من الوجوه وفي حال من الأحوال. فإن ذلك يجلب المحبة
الخالصة ويكسب الثقة التامة ويهديك محبة الغرباء ومن لا معرفة لك به.
وكما أن الحمام إذا ألف بيوتنا وآنس لمجالسنا وطاف بها يجلب لنا أشكاله وأمثاله فكذلك حال الإنسان إذا عرفنا واختلط بنا إختلاط الراغب فينا الآنس بنا. بل يزيد على الحيوان الغير الناطق بحسن الوصف وجميل الثناء ونشر المحاسن. وأعلم أن مشاركة الصديق في السراء إذا كنت فيها وإن كانت واجبة عليك حتى لا تستأثرها ولا تختص بشيء منها فإن مشاركته في الضراء أوجب وموقعها عنده أعظم. وانظر عند ذلك أن إصابته نكبة أو لحقته مصيبة أوعثر به الدهر كيف تكون مواساتك له بنفسك وما لك وكيف يظهر له تفقدك ومراعاتك. ولا تنتظرن به أن يسألك تصريحا أو تعريضا بل اطلع على قلبه وأسبق إلى ما في نفسه وشاركه في مضض ما لحقه ليخف عنه. وإن بلغت مرتبة من السلطان والغنى فاغمس إخوانك فيها من غير امتنان ولا تطاول. وإن رأيت من بعضهم نبوا عنك أو نقصانا مما عهدته فداخله زيادة مداخلة واختلط به واجتذبه إليك. فإنك إن أنفت من ذلك أو تداخلك شيء من الكبر والصلف عليهم انتقض حبل المودة وانتكثت قوته. ومع ذلك فلست تأمن أن يزولوا عنك فتستحي منهم وتضطر إلى قطيعتهم حتى لا تنظر إليهم. ثم حافظ على هذه الشروط بالمداومة عليها لتبقى المودة على حال واحدة. وليس هذا الشرط خاصا بالمودة بل هو مطرد في كل ما يخصك أعني أن مركوبك وملبوسك ومنزلك متى لم تراعها مراعاة متصلة فسدت وانتقضت. فإذا كانت صورة حائطك وسطوحك كذلك ومتى غفلت أو توانيت لم تأمن تقوضه وتهدمه فكيف ترى أن تجفو من ترجوه لكل خير وتنتظر مشاركته في السراء والضراء؟ ومع ذلك فإن ضرر تلك يختص بك بمنفعة واحدة. وأما صديقك فوجوه الضرر التي تدخل عليك بجفائه وانتقاض مودته كثيرة عظيمة. ذلك أنه ينقلب عدوا وتتحول منافعه مضارا فلا تأمن غوائله وعدواته مع عدمك الرغائب والمنافع به وينقطع رجاؤك فيما لا تجد له خلفا ولا تستفيد عنه عوضا ولا يسد مسده شيء.
وإذا
راعيت شرطوه وحافظت عليها بالمداومة أمنت جميع ذلك. ثم احذر المراء معه
خاصة وإن كان واجبا أن تحذره مع كل أحد فإن مماراة الصديق تقتلع المودة من
أصلها لأنها سبب الإختلاف والإختلاف سبب التباين الذي هربنا منه إلى ضده
وقبحنا أثره واخترنا عليه الألفة التي طلبناها وأثنينا عليها وقلنا أن
الله عز وجل دعا إليها بالشريعة القويمة. وإني لأعرف من يؤثر المراء ويزعم
أنه يقدح خاطره ويشحذ ذهنه ويثير شكوكه فهو يتعمد في المحافل التي تجمع
رؤوساء أهل النظر ومتعاطي العلوم مماراة صديقه ويخرج في كلامه معه إلى
ألفاظ الجهال من العامة وسقاطهم ليزيد في خجل صديقه وليظهر انقطاعه
وتبلجه. وليس يفعل ذلك عند خلوته به ومذاكرته له وإنما يفعله حين يظن به
أنه أدق نظرا أو أحضر حجة وأغزر علما واحدّ قريحة. فما كنت أشبهه إلا بأهل
البغي وجبابرة أصحاب الأموال والمشبهين بهم من أهل البدع فإن هؤلاء يستحقر
بعضهم بعضا ولا يزال يصغر بصاحبه ويزدري على مروءته ويتطلب عيوبه ويتتبع
عثراته ويبالغ كل واحد فيما يقدر عليه من إساءة صاحبه حتى يؤدي بهم الحال
إلى العداوة التامة التي يكون معها السعاية وإزالة النعم وتجاوز ذلك إلى
سفك الدم وأنواع الشرور. فكيف يثبت مع المراء محبة ويرجى به ألفة؟ ثم احذر
في صديقك إن كنت متحققا بعلم أو متحليا بأدب أن تبخل عليه بذلك الفن أو
يرى فيك أنك تحب الإستبداد دونه والإستئثار عليه فإن أهل العلم لا يرى
بعضهم في بعض ما يراه أهل الدنيا بينهم. ذلك أن متاع الدنيا قليل فإذا
تزاحم عليه قوم ثلم بعضهم حال بعض ونقص حظ كل واحد من حظ الآخر. وأما
العلم فإنه بالضد وليس أحد ينقص منه ما يأخذه غيره بل يزكو على النفقة
ويربو مع الصداقة ويزيد على الإنفاق وكثرة الخرج فإذا بخل صاحب علم بعلمه
فإنما ذلك لأحوال فيه كلها قبيحة. وهي أنه أما أن يكون قليل البضاعة منه
فهو يخاف أن يفنى ما عنده أو يرد عليه مالا يعرفه فيزول تشرفه عند الجهال.
وأما أن يكون مكتسبا به فهو يخشى أن يضيق مكسبه به وينقص حظه منه. وأما أن
يكون حسودا والحسود بعيد من كل فضيلة لا يوده أحد. وإني لأعرف من لا يرضى
بأن يبخل بعلم نفسه حتى يبخل بعلم غيره ويكثر عتبه وسخطه على من لا يفيد
غيره من التلامذة المستحقين لفائدة العلم. وكثيرا ما يتوصل إلى أخذ الكتب
من أصحابها ثم منعهم منها. وهذا خلق لا تبقى معه مودة بل يجلب إلى صاحبه
عداوة لا يحسبها ويقطع أطماع أصدقائه من صداقته. ثم احذر أن تنبسط بأصحابك
ومن يخلو بك من اتباعك وتحمل أحدا منهم على ذكر شيء في نفسه. ولا ترخص في
عيب شيء يتصل به فضلا عن عيبه ولا يطمعن أحد في ذلك من أولى السبائك
والمتصلين بك لا جدا ولا هزلا وكيف تحتمل ذلك فيه وأنت عينه وقلبه وخليفته
على الناس كلهم بل أنت هوفإنه إن بلغه شيء مما حذرتك منه لم يشك أن ذلك
كان عن رأيك وهواك فينقلب عدوا وينفرك عنك نفور الضد.
فإن عرفت منه أنت
عيبا فوافقه عليه موافقة لطيفة ليس فيها غلظة. فإن الطبيب الرقيق ربما بلغ
بالدواء اللطيف ما يبلغه غيره بالشق والقطع والكي بل ربما توصل بالغذاء
إلى الشفاء واكتفى به عن المعالجة بالدواء. ولست أحب أن تغضى عما تعرفه في
صديقك وأن تترك موافقته عليه بهذا الضرب من الموافقة.
فإن ذلك خيانة
منك ومسامحة فيما يعود ضرره عليه وليس من حق الصديق أن يعرف ويبذل بعيوب
الأضداد حتى يعيبوه ويثلبوه. ثم احذر النميمة وسماعها.
وذلك أن الأشرار
يدخلون بين الأخيار في صورة النصحاء فيوهمونهم النصيحة وينقلون إليهم في
عرض الأحاديث اللذيذة أخبار أصدقائهم محرفة مموهة حتى إذا تجاسروا عليهم
بالحديث المختلق يصرحون لهم بما يفسد موداتهم ويشوه وجوه أصدقائهم إلى أن
يبغض بعضهم بعضا.
وللقدماء في هذه المعنى كتب مؤلفة يحذرون فيها من
النميمة ويشبهون صورة النمام بمن يحك بأظافيره أصول البنيان القوية حتى
يؤثر فيها ثم لا يزال يزيد ويمعن حتى يدخل فيها المعقول فيقلعه من أصله
ويضربون له الأمثال الكثيرة المشبهة بحديث الثور مع الأسد في كتاب كليلة
ودمنه. ونحن تكتفي بهذا القدر من الإيماء لئلا نخرج عن رسم كتابنا وعما
بنينا عليه مذهبنا من الإيجاز في الشرح. ولست أترك مع الإيجاز والإختصار
تعظيم هذا الباب وتكريره عليك لتعلم أن القدماء إنما ألفوا فيه الكتب
وضربوا له الأمثال وأكثروا فيه من الوصايا لما رواءه من النفع العظيم عند
السامعين من الأخيار ولما خافوه من الضرر الكثير على من يستهين به من
الأغمار. وليعلم المثل المضروب في السباع القوية إذا دخل عليها الثعلب
الرواغ على ضعفه أهلكها ودمرها.
وفي الملوك الحصفاء يدخل بينهم أهل
النميمة في صورة الناصحين حتى يفسدوا نيتهم على وزرائهم المبالغين في
نصيحتهم المجتهدين في تثبيت ملكهم إلى أن يغضبوا عليهم ويصرفوا به عيونهم
منهم وإلى أن يبطشوا بهم قتلا وتعذيبا وهم غير مذنبين ولا مجترمين ولا
مستحقين إلا الكرامة والإحسان فإذا بلغ بهم من الإفساد والإضرار ما بلغوه
من هؤلاء فباللأحرى أن يبلغوه منا إذا لم يجدوه في أصدقائنا الذين
اخترناهم على الأيام وادخرناهم للشدائد وأحللناهم محل أرواحنا وزدناهم
تفضلا وإكراما.
ويتبين لك من جميع ما قدمناه أن الصداقة وأصناف المحبات
التي تتم بها سعادة الإنسان من حيث هو مدني بالطبع إنما اختلفت ودخل فيها
ضروب الفساد وزال عنها معنى التأحد وعرض لها الإنتشار حتى احتجنا إلى
حفظها والتعب الكثير بنظامها من أجل النقائص الكثيرة التي فينا وحاجتنا
إلى إتمامها مع الحوادث التي تعرض لنا من الكون والفساد. فإن الفضائل
الخلقية إنما وضعت لأجل المعاملات والمعاشرات التي لا يتم الوجود الإنساني
إلا بها. ذلك أن العدل إنما احتيج إليه لتصحيح المعاملات وليزول به معنى
الجور الذي هو رذيلة عند المتعاملين. وإنما وضعت العفة فضيلة لأجل اللذات
الرديئة التي تحي الخيانات العظيمة على النفس والبدن. وكذلك الشجاعة وضعت
فضيلة من أجل الأمور الهائلة التي يجب أن يقدم الإنسان عليها في بعض
الأوقات ولا يهرب منها وعلى هذا جميع الأخلاق المرضية التي وصفناها وحضضنا
على إقتنائها. وأيضا فإن جميع هذه الفضائل تحتاج إلى أسباب خارجة من
الأموال واكتسابها من وجوهها ليمكنه أن يفعل بها فعل الأحرار والعادل
يحتاج إلى مثل ذلك ليجازي من عاشره بجميل ويكافىء من عامله بإحسان وجميعها
لا تقوم إلا بالأبدان والأنفس وما هو خارجعنها على حسب تقسيمنا السعادات
فيما مضى.
وكلما كانت الحاجات كثيرة احتيج إلى المواد الخارجة عنا
أكثر فهذه حالة السعادات الإنسانية التي لا تتم لنا إلا بالأفعال والأحوال
المدنية وبالأعوان الصالحين والأصدقاء المخلصين وهي كما تراها كثيرة
والتعب بها عزيم ومن قصر فيها قصرت به السعادة الخاصة به. ولذلك صار الكسل
ومحبة الراحة من أعظم الرذائل لأنهما يحولان بين المرء وبين جميع الخيرات
والفضائل ويسلخان الإنسان من الإنسانية. ولذلك ذممنا المتوسمين بالزهد إذا
تفردوا عن الناس وسكنوا الجبال والمفازات واختاروا التوحش الذي هو ضد
التمدن لأنهم ينسلخون عن جميع الفضائل الخلقية التي عددناها كلها. وكيف
يعف ويعدل ويسخو ويشجع من فارق الناس وتفرد عنهم وعدم الفضائل الخلقية.
وهل هو إلا بمنزلة الجماد والميت وأما محبة الحكمة والإنصراف إلى التصور
العقلي وإستعمال الآراء الإلهية فإنها خاصة بالجزء الإلهي من الناس وليس
يعرض لها شيء من الآفات التي تعرض للمحبات الأخرى الخلقية وضروب الفساد
ولذلك قلنا أنها لا تقبل النميمة ولا نوعا من أنواع الشرور لأنها الخير
المحض وسببها الخير الأول الذي لا تشوبه مادة ولا تلحقه الشرور التي في
المادة وما دام الإنسان يستعمل الأخلاق والفضائل الإنسانية فإنها تعوقه عن
هذا الخير الأول وهذه السعادة الإلهية ولكن ليس يتم له إلا بتلك ومن أصل
تلك الفضائل بنفسه ثم اشتغل عنها بالفضيلة الإلهية فقد اشتغل بذاته حقا
ونجا من مجاهدات الطبيعة والآمها ومن مجاهدات النفس وقواها وصار مع
الأرواح الطيبة واختلط بالملائكة المقربين فإذا انتقل من وجوده الأول إلى
وجوده الثاني حصل في النعيم الأبدي والسرور السرمدي.
؟رأى أرسطوطاليس
في السعادة التامة وقد أطلق أرسطوطاليس جميع هذه الألفاظ وقال أن السعادة
التامة الخالصة هي لله عز وجل ثم للملائكة والمتأهلين. ثم قال ولا ينبغي
أن يضاف إلى الملائكة تلك الفضائل التي عددناها في سعاد الإنسان فإنهم لا
يتعاملون ولا يكون عند أحد منهم وديعة فيحتاج إلى ردها ولا لأحد منهم
تجارة فيحتاج إلى العدالة ولا يفزعه شيء فيحتاج إلى النجدة ولا له نفقات
فيحتاج إلى الذهب والفضة ولا له شهوات فيحتاج إلى ضبط النفس وإلى فضيلة
العفة ولا هو مركب من الإستقصات الأربعة التي تحل في أضدادها فيحتاج إلى
الغذاء.
فإذا هؤلاء الأبرار المطهرون من بين خلق الله عز وجل غير
محتاجين إلى الفضائل الإنسية والله تعالى وتقدس وجل أعلى من ملائكته فيجب
أن ننزه عن جميع ماذكرناه من فضائل الإنسان وإنما نذكره بالخير البسيط
الذي يشبهه وننسب إليه الأمور العقلية التي تليق به. فبالحق الواجب الذي
لا مرية فيه لا يحبه إلا السعيد الخير من الناس الذي يعرف السعادة والخير
بالحقيقة فلذلك يتقرب إليه بهما جهده ويطلب مرضاته بقدر قاته ويتقبل أوامر
بنحو استطاعته. ومن أحب الله تعالى هذه المحبة وتقرب إليه هذا التقرب
وأطاعه هذه الطاعة أحبه الله وقربه وأرضاه وأستحق خلته التي أطلقتها
الشريعة على بعض البشر حيث قيل إبراهيم خليل الله، وأما أرسطوطاليس فإنه
أطلق بعد ذلك بالعلة شيئا غير مطلق في لغتنا. وذلك أنه قال (من أحب الله
وتعاهده كما يتعاهد الأصدقاء بعضهم بعضا أحسن إليه) ولذلك يظن بالحكيم
اللذات العجيبة وضروب الفرح الغريبة ويرى من تحقق بالحكمة أنها ملذة غاية
الإلتذاذ فلا يلتفت إلى غيرها ولا يعرج على سواها. وإذا كان الأمر على ما
وصفنا فالحكيم السعيد التام الحكمة هو الله تعالى فليس يحبه إلا السعيد
الحكيم بالحقيقة لأن الشبيه إنما يسر بشبيهه فقط. ولذلك صارت هذه السعادة
ارفع وأعلى من تلك السعادة التي ذكرناها وهي غير منسوبة إلى الإنسان لأنها
مهذبة من الحياة الطبيعية مبرأة من التقوى النفسانية مباينة لجميعها غاية
المباينة وإنما هي موهبة إلهية يهبها الباريب جلت عظمته لمن إصطفاه من
عباده ثم التمسها منه وسعى لها سعيها ورغب فيها ولزمها مدة حياته واحتمل
المشقة والتعب فإن من لم يصبر على إدامة التعب إشتاق اللعب؟.
الراحة البدنية ليست من أسباب السعادة
ذلك
أن اللعب يشبه الراحة والراحة ليست من تمام السعادة ولا من أسبابها وإنما
يميل إلى الراحات البدنية من كان طبيعي الشكل بهيمي النجار كالعبيد
والصبيان والبهائم فليس ينسب الحيوان غير الناطق ولا الصبيان والعبيد إلى
السعادة ولا من كان مناسبا لهم. وأما العاقل الفاضل فإنه يطلب بهمته أعلى
المراتب وأرسطوطاليس يقول لا ينبغي أن تكون همم الإنسان إنسية وإن كان
إنسانا ولا يرضى بهم الحيوان الميت وإن كان هو أيضا ميتا بل يقصد بجميع
قواه أن يحيا حياة إلهية فإن الإنسان وإن كان صغير الجثة فهو عظيم بالحكمة
شريف بالعقل. والعقل يفوق جميع الخلائق لأنه الجوهر الرئيس المستولي على
الكل بأمر مبدعه تعالى جده) وقد قلنا فيما تقدم إن الإنسان ما دام في هذا
العالم فهو محتاج إلى حسن الحال الخارجة عنه ولكن ينبغي أن ينصرف إلى طلب
ذلك بقوته كلها ولا يطلب الإستكثار منه. فقد يصل إلى الفضيلة من ليس بكثير
المال ولا ظاهر اليسار فإن الفقير من المال والأملاك قد يفعل الأفعال
الكريمة ولذلك قالت الحكماء. إن السعداء هم الذين رزقوا القصد من الخيرات
الخارجة عنهم وفعلوا الأفعال التي تقتضيها الفضيلة وإن كانت فيهم قليلة:
هذا كلام الحكيم في هذه المرتبة التي وعدناك الكلام فيها وهو يقول بعد ذلك
ليس في معرفة الفضائل كفاية بل الكفاية في العمل بها. ومن الناس من ينصاع
إلى الفضائل وينقاد إلى الموعظة ويرغب في الخيرات وهؤلاء قليلون وهم الذين
يمتنعون من جميع الردآت والشرور. وذلك للغريزة الجيدة والطبع الجيد
الفائق. ومنهم من ينقاد إلى الخيرات حتى يمتنع من الردآت والشرور بالوعيد
والفزع والإنذارات من العذاب فيهرب من الجحيم والهاوية وما أعد فيها من
الآلام. ولذلك حكمنا أن بعض الناس أخيار بالطبع وبعضهم أخيار بالشرع
وبالتعلم.
فالشريعة تجري لهؤلاء جرى الماء للإنسان الذي به يسيغ غصه.
ومن لا ينقاد لها فهو كالشرق بالماء فلا يشرب الماء ولا يجده يسيغ غصته
وهو الهالك الذي لا حيلة فيهولا طمع في إصلاحه وبرئه. ولهذه العلة قلنا:
إن من كان بالطبع خيرا فاضلا فذلك لمحبة الله إياه وليس أمره إلينا ولا
نحن كنا سببه بل الله عز وجل. ومثل هذا هو الذي يقول فيه ارسطوطاليس أن
عناية الله به أكبر. فتحصل مما قدمناه أن أنصاف السعداء من الناس أربعة
وهم موجودون بالتصفح والحس. وذلك أنا نجد من الناس من هو خير فاضل من مبدأ
تكوينه نرى فيه النجابة طفلا ونتفرس فيه الفلاحة ناشئا بأن يكون حيا كريم
الخيم يؤثر مجالسة الأخيار ومؤانسة الفضلا وينفر من اضدادهم وليس يكون
بذلك غلا بعناية تلحقه من أول مولده كما قلناه. ونجد أيضا من لا يكون بهذه
الصفة من مبداء تكوينه بل يكون كسائر الصبيان إلا أنه يسعى ويجتهد ويطلب
الحق إذا رأى اختلاف الناس فيه ولا يزال كذلكحتى يبلغ مرتبة الحكماء أعني
أن يصير علمه صحيحا وعمله صوابا. وليس يبلغ هذه الدرجة إلا بالتفلسف
وإطراح العصببات وسائر ما حذرنا منه، ونجد أيضا من يوجد بهذه السيرة أخذا
على الإكراه. إما بالتأديب الشرعي. وإما بالتعليم الحكمي. ومعلوم أن
المطلوب هو القسم الثاني إذا كانت الأقسام الباقية هي من خارج ولا يمكن أن
تطلب أعني أن من يتفق له في أصل مولده السعادة ومن يكره عليها ليس من
أقسام الطالب المجتهد وتبين أيضا مقام الطالب المجتهد ومنزلته من السعادة
التامة الحقيقية وأنه وحده من بين سائر الطبقات هو السعيد الكامل المقرب
إلى الله عزوجل المحب المطيع المستحق خلته ومحبته كما تقدم وصفه.
؟المقالة
السادسة دواء النفوس نبتدىء بعون الله وتوفيقه وتأييده في هذه المقالة
بذكر شفار الأمراض التي تلحق نفس الإنسان وعلاجها ونذكر الأسباب والعلل
التي تولدها وتحدث منها فإن حذاق الأطباء لا يقدمون على علاج مرض جسماني
إلا بعد أن يعرفوه ويعرفوا السبب والعلة فيه ثم يرومون مقابلته بأضداده من
العلاجات ويبتدؤن من الحمية والأدوية اللطيفة إلى أن ينتهوا في بعضها إلى
إستعمال الأغذية الكريهة والأدوية البشعة وفي بعضها إلى القطع بالحديد
والكي بالنار.
ولما كانت النفس قوة إلهية غير جسمانية وكانت مع ذلك
مستعملة لمزاج خاص ومربوطة به رباطا طبيعيا إلهيا لا يفارق أحدهما صاحبه
إلا بمشيئة الخالق عز وجل وجب أن نعلم أن أحدهما متعلق بصاحبه متغير
بتغيره فيصبح بصحته ويمرض بمرضه ونحن نرى ذلك مشاهدة وعيانا بما يظهر لنا
من أفعالها.
وذلك أنا كمانرى المريض من جهة بدنه لا سيما إن كان سبب
مرضه أحد الجزئين الشريفين أعني الدماغ والقلب يتغير عقله ويمرض حتى ينكر
ذهنه وفكره وتخيله وسائر قوى نفسه الشريفة ويحس هو من نفسه بذلك. كذلك
أيضا، نرى المريض من جهة نفسه إما بالغضب وإما بالحزن وإما بالعشق وإما
بالشهوات الهائجة به تتغير صورة بدنه حتى يضطرب ويرتعد ويصفر ويحمر ويهزل
ويسمن ويلحقه ضروب التغير المشاهدة بالحس. فيجب لذلك أن نتفقد مبدأ
الأمراض إذا كان من نفوسنا فإن كان مبدؤها من ذاتها كالفكر في الأشياء
الرديئة وإجالة الرأى فيها وكاستشعار الخوف والخوف من الأمور العارضة
والمترقبة والشهوات الهائجة قصدنا علاجها بما يخصها. وإن كان مبدؤها من
المزاج ومن الحواس كالخور الذي مبدأه ضعف حرارة القلب مع الكسل والرفاهي
وكالعشق الذي مبدأه النظر مع الفراغ والبطالة قصدنا أيضا علاجه بما يخص
هذه.
وأيضا لما كان طب الأبدان ينقسم بالقسمة الأولى إلى قسمين أحدهما
حفظ صحتها إذا كانت حاضرة والآخر ردها إليها. إذا كانت غائبة وجب أن نقسم
طب النفسو هذه القسمة بعينها فنردها إذا كانت غائبة ونتقدم في حفظ صحتها
إذا كانت حاضرة فنقول إذا كانت خيرة فاضلة تحب نيل الفضائل وتحرص على
إصابتها وتشتاق إلى العلوم الحقيقية والمعارف الصحيحة فيجب على صاحبها أن
يعاشر من يجانسه ويطلب من يشاكله. ولا يأنس بغيرهم ولا يجالس سواهم. ويحذر
كل الحذر من معاشرة أهل الشر والمجون والمجاهرين بإصابة اللذات القبيحة
وركوب الفواحش المتفتخرين بها المنهمكين فيها ولا يصغى إلى أخبارهم مسطيبا
ولا يروى أشعاهم مستحسنا ولا يحضر مجالسهم مبتهجا. وذلك أن حضور مجلس واحد
من مجالسهم وسماع خبر واحد من أخبارهم يعلق من وضره ووسخه بالنفس ما لا
يغسل عنها إلا بالزمان الطويل والعلاج الصعب وربما كان سببا لفساد الفاضل
المحنك وغواية العالم المستبصر حتى يصير فتنة لهما فضلا عن الحدث الناشىء
المسترشد.
والعلة في ذلك أن محبة اللذات البدنية والراحات الجسمية
طبيعة للإنسان لأجل النقائص التي فيه فنحن بالجبلة الأولى والفطرة السابقة
إلينا نميل إليها ونحرص عليها وإنما نزم أنفسنا عنها بزمام العقل حتى نقف
عند ما يرسم لنا ونقتصر على المقدار الضروري منها. وإنما استتنيت في أول
هذا الكلام وشرطت بما شرطت لأن معاشرة الأصدقاء الذين ذكرت أحوالهم في
المقالة المتقدمة وحكمت بتمام السعادة معهم ولهم. لا تتم إلا بالمؤانسة
والمداخلة.
اللذة التي تطيقها الشريعة
ولا بد في ذلك من المزاح المستعذب والأحاديث المستطابة والفكاهة المحبوبة وإصابة اللذة التي تطيقها الشريعة ويقدرها العقل حتى لا يتجلوزها إلى الإسراف فيها ولا يقصرعنها تهاونا بها.ذلك أن الخروج إلى أحد الطرفين إن كان إلى جانب
الزيادة سمى مجونا وفسقا وخلاعة وما أشبهها من أسماء الذم. وإن كان إلى
جانب النقصان سمى فدامة وعبوسا وشكاسة وما أشبهها من أسماء الذم أيضا.
والمتوسط بينهما هوالظريف الذي يوسف بالهشاشة والطلاقة وحسن العشرة ويعرض
من الصعوبة في وجود هذا الوسط ما يعرض في سائر الفضائل الخلقية. ومما يؤخذ
به من يحفظ صحة نفسه أن يلتزم وظيفة من الجزء النظري والعملي لا يسوغ له
الإخلال بها البتة لتجري النفس مجرى الرياضة التي تلزم في حفظ صحة البدن
وأطباء النفوس أشد تعظيما لها في حفظ صحة النفس. وذلك أن النفس متى تعطلت
من النظر وعدمت الفكر والغوص على المعاني تبلدت وتبلهت وانقطت عنها مادة
كل خير. وإذا ألفت الكسل وتبرمت بالروية واختارت العطلة قرب هلاكها لأن في
عطلتها هذه إنسلاخا من صورتها الخاصة بها ورجعوعا منها إلى رتبة البهائم.
وهذا هو الإنتكاس في الخلق نعوذ بالله منه. وإذا تعود الحديث الناشء من
مبدء تكوينه الإرتياض بالأمور الفكرية ولازم التعاليم الأربعة ألف الصدق
واحتمل ثقل الروية والنظر وأنس بالحق ونبا طبعه عن الباطل وسمعه عن الكذب
فإذا بلغ أشده وانتقل إلى مطالعة الحكمة استمر طبعه فيها وتشرب ما يستودع
منها ولا يرد عليه أمر غريب ولا يحتاج إلى كثير تعب في فهم غوامضها
وإستخراج دفائنها فيصل إلى سعادتها التي ذكرناها سريعا. وإن كان حافظ هذه
الصحة قد توحد في العلم لا نهاية له وفوق كل ذي علم عليم. ولا يتكاسلن عن
معاودة ما علمه والدرس له فإن النسيان آفة العلم وليتذكر قول الحسن البصري
رحمة الله عليه (اقدعوا هذه النفوس فإنها طائعة وحادثوها فإنها سريعة
الدثور) واعلم أن هذه الكلمات مع قلة حروفها كثيرة المعاني وهي مع ذلك
فصيحة واستوفت شروط البلاغة. وليعلم أيضا حافظ هذه الصحة على نفسه أنه
إنما يحفظ عليها نعما شريفة جليلة موهوبة لها وكنوزا عظيمة مدخرة فيها
وملابس فاخرة مفرغة عليها. وإن من كانت هذه المواهب الجليلة موجودة له في
ذاته لا يحتاج إلى تطليها من خارج ولا إلى بذل الأموال فيها لغيره ولا
يكلف العناء والمؤمن الثقال في تحصيلها ثم أعرض عنها وأهمل أمرها حتى
انسلخ عنها وعرى منها لملوم في فعله مغبون في رأيه غير رشيد ولا موفق.
لا
سيما وهو يرى طالبي النعم الخارجة كيف يتجشمون الأسفار البعيدة الخطرة
ويقطعون السبل المخوفة الوعرة ويتعرضون لضروب المكاره وأنواع التلف من
السباع العادية وطبقات الشرار الباغية وهم يخيبون في أكثر الأحوال مع
مقاسات هذه الأهوال. وربما عرضت لهم الندامات المفرطة والحسرات المعطبة
التي تقطع أنفساهم وتفصل أعضاءهم فإن ظفروا بشيء من مطالبهم كان لا محالة
زائلا عن قرب أو معرضا للزوال وغير مطموع في بقائه لأنه منخارج وما كان
خارجا عنها فهو غير ممتنع عما يطرقه من الحوادث التي لا تحصى كثرة. وصاحبه
مع هذه الحال شديد الوجل دائم الإشفاق متعب الجسم والنفس يحفظ ما لا يجد
إلى حفظه سبيلا والحذر على مالا يغني فيه الحذر فتيلا.
وإن كان طالب
هذه الأشياء الخارجة عنا سلطانا أو صاحب سلطان تضاعفت عليه هذه المكاره
أضعافا كثيرة بقدر ما يلابسه وبحسب ما يقاسيه من الأضداد والحساد على
البعد ومن القرب وبكثرة ما يحتاج إليه من المؤن في إستصلاح من يليه ويلي
من يليه من مدارة من يواليه ويعاديه. وهو في كل ذلك ملوم مستبطأ ومعتب
مستقصر ويستزيده جميع أهله والمتصلين به ولا سبيل له إلى إرضاء واحد منهم
فضلا عن جميعهم. ولا يزال يبلغه عن أخص الناس به من أولاده وحرمه ومن يجري
مجراهم من حاشيته وخوله ما يملأه غيظا وحنقا وهو غير آمن على نفسه من
جهتهم مع التحاسد الذي بينهم من مكاتبة الأعداء إياهم ومواطأة الحساد لهم.
وكلما ازداد من الأعوان والأعضاد والأنصار زادوه في شغل القلب وجلبوا إليه
من المكاره ما لم يكن عنده فهو غنى عند الناس وهو أشدهم فقرا ومحسود وهو
أكثرهم حسدا. وكيف لا يكون فقيرا وحدا الفقر هو هو كثرة الحاجة فأكثر
الناس حاجة أشدهم فقرا كما أن أغنى الناس أقلهم حاجة. ولذلك حكمنا حكما
صادقا بأن الله تعالى أغنى الأغنياء لأنه لا حاجة له إلى شيء من الأشياء.
الملوك
وقد
حكمنا أيضا أن الملوك مناهم أشد الناس فقرا لكثرة حاجتهم إلى الشياء ولقد
صدق أبو بكر الصديق في خطبته حيث قال (اشقىالناس في الدنيا والآخرة
الملوك) ثم وصفهم فقال (إنالملك إذا ملك زهده الله فيما في يده ورغبه فيما
في يد غيره وانتقصه شطر أجله وأشرب قلبه الإشفاق فهو يحسد على القليل
ويتخسط بالكثير ويسأم الرخاء وإن انقطعت عنه اللذة لا يستعمل الغيرة ولا
يسكن إلى الثقة فهو كالدرهم الغش والسراب الخادع جلد الظاهر حزين الباطن
فإذا وجبت نفسه ونضب عمره ومحي ظله حاسبه فأشد حسابه وأقل عفوه ألا أن
الملوك هم المرحومون) فهذه صفة الملك إذا تمكن من ملكه لا يغادر منه شيئا
ولقد سمعت أعظم من شاهدت من الملوك يستعيد هذا الكلام ثم يستعبر لموافقته
ما في قلبه وصدقه عن حاله وصورته. ولعل من يرى ظاهر الملوك من الأسرة
والفرش والزينة والأثاث ويشاهدهم في مواكبهم محفوفين محشودين بين أيديهم
الجنائب والمراكب والعبيد والخدم والحجاب والحشم يروعه ذلك فيظن أنهم
مسرورون بما يراه لهم. لا والذي خلقهم وكفانا شغلهم أنهم لفي هذه الأحوال
ذاهلون عما يراه البعيد لهم مشغولون بالأفكار التي تعتورهم وتعتريهم فيما
قلناه من ضروراتهم وقد جربنا ذلك في اليسير مما ملكناه فدلنا على الكثير
مما وصفناه. ولعل بعض من يصل إلى الملك أو السلطان فيلتذ في المبدء مدة
يسيرة جدا بمقدار ما يتمكن منه وتنفتح عينه فيه. لكنه بعد ذلك يصير جميع
ما ملكه كالشيء الطبيعي له لا يلتذ به ولا يفكر فيه ويمد عينه إلى مالا
يملكه. فلو ملك الدنيا بحذافيرها لتمنى دنيا أخرى أو نزقت همته إلى البقاء
الأبدي والملك الحقيقي حتى تتبرم بجميع ما وصل إليه وبلغته قدرته. ذلك أن
حفظ الدنيا صعب جدا لما في طبيعتها من الإخلال والتلاشي ولما يضطر الملك
إليه من الأمور التي وصفناها والأموال الجمة المصروفة إلى الجند المرتبطين
والخدم المتسومين والذخائر والكنوز المعدة للآفات والحوادث التي لا يؤمن
طروقها.
فهذه حال طلاب النعم الخارجة عنا وأما تلك النعم التي في
ذواتنا فإنها موجودة عندنا وفينا وهي غير مفارقة لنا لأنها موهبة الخالق
جل وعلا وقد أمرنا باستثمارها والترقي فيها فإذا قبلنا أمره أثمرت لنا
نعما بعد نعم ورقينا درجة بعد درجة حتى تؤدينا إلى النعم الأبدية التي
وصفناها فيما تقدم وهو الملك الحقيقي الذي لا يزول والغبطة الأبدية
الصافية التي لا تحول. فمن أخسر صفقة وأظهر سقطة ممن أضاع جواهر نفيسة
باقية عنده وموجودة له وطلب أعراضا خسيسة فانية ليست عنده ولا موجودة له.
فإن اتفق أن يجدها لم تبق له ولم تترك عليه وذلك أنها تنقل عنه أو ينقل
عنها لا محالة.
القناعة
لذلك قال الحيكم لمن زرق الكفاية ووجد القصد من السعادة الخارجة أن لا يشتغل بفضول العيش فإنها بلا نهاية. ومن طلبها أوقعته في مهالك لا نهاية لها. وقد أعلمناك فيما تقدم ما الكفاية وما القصد وإن الغرض الصحيح بينهما هو مداواة الآلآم والتحرز من الوقوع فيها لا التمتع وطلب اللذة.وإن من عالج الجوع والعطش اللذين هما مرضان مؤلمان حادان لا ينبغي له أن يقصد لذة البدن بل صحته وسيلتذ لا محالة. فإن من طلب بالعلاج اللذة لا الصحة لم تحصل له الصحة ولم تبق له اللذة.
وأما من لم يرزق الكفاية واحتاج إلى السعي والإضطراب في تحصيلها فيجب أن لا يتجاوز القصد وقدر حاجته منها إلى ما يصطر معه إلى السعي الحثيث والحرص الشديد والتعرض لقبيح المكاسب أو ضروب المهالك والمعاطب. بل يجمل في طلبها إجمال العارف بخساستها وأنه يضطر إليها لنقصانه فيطلب منها كسائر الحيوانات في ضروراتها.
فإن العاقل إذا تصفح أحوالها وجد منها ما يأكل الميتة ومنها ما يأكل الروث وما في الحش وهي مسرورة بما تجده من أقواتها قريرة العين بها. وليست تحس من نفوسها نفورا ولا تنصرف نفوسها عنها كما تنصرف نفوس الحيوانات المضادة لها بل إنما تنصرف من أقوات تلك الأخر التي تضادها في النظافة. مثال ذلك الجعل والخنافس إذا قيست إلى النحل فإذا تلك تهرب من الروائح الطيبة والأقوات النظيفة وهذا يطلبها ويسر بها. فإن نسبة كل حيوان إلى قوته الخاص به ككل مقتنع بما يحفظ بقاءه وحياته فهو طالب مسرور به.
فينبغي أن ننظر إلى أقواتنا بهذه العين
وننزلها منزلة الحش الذي نضطر إلى ملابسته لإخراج ما كنا نحرص على الوصول
إليه فلا نبعدها من هذا الآخر لأنهما ضرورتان لنا فنحن نلابسهما لأجل
الضرورة ولا نشغل عقلنا باختيارهما والتمتع بهما وإفناء أعمارنا في التأنق
لهما والتوصل إليهما ولا نتكاسل أيضا عن إعداد ضروراتنا منهما. وإنما يفضل
أحدهما علىالآخر ويستحسن السعي في طلب الدخل ولا يستحسن السعي في طلب
الخرج لأن الأول منهما هو غذاء موافق لنا يخلف علينا ماتحلل من أبداننا
ولا نستقذره كذلك لا ننفر مما نضعه مكان ما ينقص منه وينوب عنه. وأما
الثاني منهما فهو عصارة ذلك الغذاء وما نفقته الطبيعة وأخذت حاجتها منه
أعني الذي أحالته دما صافيا وفرقته في العروق على الأعضاء وأطرحت التفل
الذي لا حاجة بها إليه وهو في غاية المخالفة والبعد من أمزجتنا فنحن
نستوحش منه وننفر عنه لأجل الضدية والمخالفة إلا أننا مضطرون إلى إخراجه
وتنحيته ونفضه عنا بالآلات الموهوبة المستعملة في ذلك ليفرغ مكانه لما
يأتي بعده ويجري مجراه. وينبغي لحافظ الصحة علىنفسه أن لا يحرك قوته
الشهوانية وقوته الغضبية بتذكر ما أصاب منهما موجدا لذته بل يتركهما حتى
يتحركا بأنفسهما وذلك أن الإنسان ربما تذكر لذاته في غصابة الشهوات وطيبها
ومراتب كرامته من السلطان وغيرها فاشتاق إليها وإذا اشتلق إليها تحرك
نحوها فقد جعلها غرضا له فيضطر إلى استعمال الروية واستخدام النفس الناطقة
فيها لتدبر له الوصول إليها. وهذه صورة من يثير بهائم عادية ويهيج سباعا
ضاربة ثم يلتمس معالجتها والخلاص منها.
وليس يختار العاقل فنسه هذه
الحال بل هي من أفعال المجانين الذين لا يميزون بين الخير والشر ولا بين
الصواب والخطأ. ولذلك يحب أن لا يتذكر أعمال هاتين القوتين لئلا يشتاق
إليهما ويتحرك نحوهما بل يتركهما فإنهما سيثوران لأنفسهما ويهيجان عند
حاجتهما ويلتمسان ما يحتاج البدن إليه ويتخذان من باعث الطبيعة ما يغنيك
عن بعثهما بالفكر والروية والتمييز فيكون حينئذ فكرك وتمييزك في إزاحة
علتهما وتقدير ما تطلقه لهما في الأمر الضروري الواجب لأبداننا الحافظ
لصحتها.
وهذا هو إمضاء مشيئة الله تعالى وإتمام سياسته لأنه تعالى
إنماوهب هاتين القوتين لنا لنستخدمهما عند حاجتنا إليهما لا لنخدمهما
ونتعبد لهما.
فكل من استعمل النفس الناطقة في خدمة عبدها فقد تجاوز أمر
الله وتعدة حدوده وعكس سياسته وتقديره. وذلك أن خالقنا عز وجل رتب لنا هذه
القوى بتدبيره وتقديره ولا عدل اشرف وأفضل من ترتيبه وتقديره وكل من خالفه
وعدل عنه فهو أعظم على ذاته وأكبر ظالم لنفسه.
حافظ الصحة على نفسه
ينبغي
لحافظ الصحة علىنفسه أن يلطف نظره في كل ما يعمل ويدربر ويستعمل فيه آلات
بدنه ونفسه لئلا يجري فيها على عادة تقدمت له مخالفة لما يوجب تمييزه
ورويته فما أكثر ما يعرض للإنسان من بدو أفعال تخالف ما قدم فيه عزيمته
وعقد عليه رأيه. فمن عرض له مثل هذا فيجب عليه أن يضع لنفسه عقوبات يقابل
بها أمثال هذه الذنوب فإذا أنكر من نفسه مبادرة إلى طعام ضار وترك حمية قد
كان استشعرها أو تناول فاكهة غير موافقة أو حلواء كذلك عاقب نفسه بصوم لا
يفطر فيه إلا على ألطف مما يقدر عليه وأقله وإن أمكنه الطى فليطو ويزيد في
الحمية من غير حاجة إليها ويمكن في توبيخه لنفسه أن يقول لها إنك قصدت
تناول النافع فتناولت الضار وهذا فعل من لا عقل له ولعل كثيرا من البهائم
أحسن حالا منك لأنه ليس فيها ما تقصد لذة لها ثم تتناول ما يؤلمها
فاستمسكي الآن للعقوبة. وإن أنكر من نفسه مبادرة إلى غضب في غير موضعه أو
على من لا يستحقه أو زيادة على ما يجب منه فليقابل ذلك بالتعرض لسفيه
يعرفه بالبذاء ثم ليحتمله وليتذلل لمن يعرفه بالخيرية ممن كان لا يتواضع
له قبل ذلك أو ليفرض على نفسه مالا يخرجه صدقة وليجعل ذلك نذرا عليه لا
يخل به. وإن أنكر من نفسه كسلا وتوانيا في مصلحة له فليعاقب نفسه بسعي فيه
مشقة أو صلاة فيها طول أو بعض الأعمال الصالحة التي فيها كد وتعب وبالجملة
فليرسم علىنفسه رسوما تصير عليها فرائض وحدودا لا يخل بها ولا يترخص فيها
إذا أنكر من نفسه مخالفة لعقله وتجاوزا لمرسومه. وليحذر في جميع أوقاته
ملابسة رذيلة أو مساعدة رفيق عليها أو مخالفة صواب ولا يستحقرن شيئا مما
يأتيه من صغار السيئات ولا يطلبن رخصة فيها فإن ذلك يدعوه إلى أعظم منها.
ومن
تعود في أول نشوه وحدثان شبابه ضبط النفس عن شهواتها عند ثورة غضبه وحفظ
لسانه وإحتمال أقرانه خف عليهما يثقل على غيره ممن لم يتأدب بهذه الآداب.
وبيان ذلك أنا نجد العبيد وأشباههم إذا بلوا بموالي سوء يسفهون عليهم
ويسبون أعراضهم هان عليهم الخطب فيما يسمعونه حتى لا يؤثر فيهم وربما
تضاحكوا عند سماع مكروه شديد ضحكا غير متكلف ويعملون عند ذلك أعمالهم
ودعين طلقين غير قلقين وقد كانوا قبل ذلك شرسين غضوبين غير محتملين ولا
ممسكين عن الأجوبة والإنتقام بالكلام وطلب التشقي بالخصام. وهذه سبيلنا
إذا ألفنا الفضائل وتجنبنا الرذائل وأمسكنا عن مقابلة السفهاء ومجاراتهم
والإنتقام منهم. ويجب على حافظ الصحة على نفسه أن يتشبه بالملوك الموصوفين
بالحزم فإنهم يستعدون للأعداء بالعدة والعتاد والتحصن قبل هجوم العدو وهم
في مهلة من زمانهم وفي إتساع من نظرهم ولو أغفلوا ذلك إلى أن تحل بهم
المكاره وتطرقهم الشدائد لأذهلهم الأمر عن الحيلةوعن الرأي السديد. فعلى
هذا الأصل يجب أن تبنى أمورنا في الإستعداد لأعدائنا من الشره والغضب
وسائر ما يزيلنا عن أغراضنا من الفضائل بأن نتعود الصبر على ما يجب الصبر
عليه والحلم عمن ينبغي أن يحلم عنه ونضبط النفس عن الشهوات الرديئة ولا
ننظر دفع هذه الرذائل وقت هيجانها فإن الأمر عند ذلك صعب جدا ولعله غير
ممكن ألبتة.
معرفة المرء عيوب نفسه
ويجب علىحافظ الصحة علىنفسه ان يطلب عيوب نفسه باستقصاء شديد ولا يقنع بما قاله جالينوس في ذلك فإنه ذكر في كتابه المعروف بتعرف المرء عيوب نفسه " أنه لما كل إنسان يجب نفسه خفيت عليه معايبهولم يرها وإن كانت ظاهرة " وأشار في كتابه هذا بان يختار من يحب أن يبرأ من العيوب صديقا كاملا فاضلا فيخبره بعد طول المؤانسة إنه إنما يعرف صدق مودته إذا أصدقه عن عيوبه حتى يتجنبها ويأخذ عهده على ذلك ولا يرضى منه إذا قال له لا أعرف لك عيبا بل ينكر عليه ويعلمه أنه قد أتهمه بالخيانة ويعاود مسئلته والإلحاح عليه.فإذا لم يخبره من عيوبه زاد في العتب الصريح وافلحاح قليلا فإذا أخبره ببعض ما يعثر عليه منه فلا يظهر له في وجهه أو كلامه نكرة ولا انقباضا بل يبسط له وجهه ويظهر السرور بما أخرجه إليه ونبهه عليه ويشكره على الأيام وفي أوقات المؤانسة ليتطرق له إلى إهداء مثله إليه ثم يعالج ذلك العيب بما يزيل أثره ويمحو ظله ليعلم ذلك المهدي إليك عيبك أنك من وراء نفسك وفي طريق علاج مرضك فلا ينقض عن معادوتك ونصيحتك.
وهذا الذي أشار به جالينوس معوز غير
موجود ولا مطموع فيه. وفلعل العدو في هذا الموضع أنفع من الصديق فإن العدو
لا يحتشمنا في إظهار عيوبنا بل يتجاوز ما يعرف منا إلى التحرض والكذب فيها.
فلنتنبه
على كثير من عيوبنا من جهتها بل نتجاوز إلى ذلك أن نتهم نفوسنا بما ليس
فيها. ولجالينوس أيضا مقالة يقول فيها أن خيار الناس ينتفعون بأعدائهم
وهذا صحيح لا يخالفه فيه أحد وذلك لما ذكرناهز فأما ما اختاره أبو يوسف بن
إسحاق الكندي في ذلك فهو ماحكاه بألفاظه وهو هذا قال: (ينبغي لطالب
الفضيلة لنفسه أن يتخذ صور جميع معارفه من الناس مرآة له تريه صور كل واحد
منهم عندما تعرض له آلام الشهوات التي تثمر السيئات حتىلا يغيب عنه شيء من
السيئات التي له. وذلك أنه يكون متفقدا سيئات الناس فمتى رأى سيئة بادية
من أحد ذم فنسه عليها كأنه هو فعلها وأكثر عتبه على نفسه من أجلها ويعرض
عليها كل يوم وليلة جميع أفعاله حتى لا يشذ عنه شيء منها فإنه قبيح بنا أن
نجتهد في حفظ ما نقضناه من الحجارة الدنيئة والأرمد الهامدة الغريبة منا
التي لا ينقصنا عدمها ألبتة في كل يوم ولا نحفظ ما ينفق من ذواتنا التي
بتوفيرها بقاؤنا وبنقصانها فناؤنا. فإذا وقفنا على سيئة من أفعالنا اشتد
عذلنا لأنفسنا عليها ثم لنقيم عليها حدا نفرضه ولا نضيعه. وإذا تصفحنا
أفعال غيرنا ووجدنا فيها سيئة عاتبنا أيضا نفوسنا عليها فإن نفوسنا ترتدع
حينئذ عن المساوي وتألف الحسنات وتكون المساوي أبدا ببالنا لا ننساها ولا
يأتي عليها زمان طويل فيعفى ذكرها.
ولذلك ينبغي أن نعمل في الحسنات
لنفرغ إليها ولا يفوتنا منها شيء. قال: وينبغي أن لا نقطع بأن نصير أشباه
الدفاتر والكتب التي تفيد غيرها معاني الحكمة وهي عادمة اقتنائها أو
كالمسن يشحذ ولا يقطع بل نكون كالشمس التي تفيد القمر كلنا أشرقت عليه
إنارة من ذلتها فتفعل له تماما حتى يكون له شبهها وإن قصر عن نورها. فهكذا
ينبغي أن يكون حالنا إذا أفدنا غيرنا الفضائل) وهذا الذي ذكره الكندي في
ذلك أبلغ مما قاله من تقدمه.
المقالة السابعة
رد الصحة على النفس
رد الصحة على النفس إذا لم تكن حاضرة وهو القول في علاج أمراضها ونبتدىء بمعونة الله تعالى بذكر أجناس هذه الأمراض الغالبة ثم بمداواة الأعظم فالأعظم منها نكاية والأكثر فالأكثر جناية فنقول: أما أجناسها الغالبة فهي مقابلات الفضائل الأربع التي أحصيناها في مبدأ الكتاب.ولما كانت الفضائل أوساطا محمودة وأعيانا موجودة أمكن أن تطلب وتقصدن وتنتهي إليها الحركة والسعي والإجتهاد.
وأما سائر النقد التي ليست بأوساط فإنها غير محودة ولا أعيانها موجودة ووجودها بالعرض لا بالذات. ومثال ذلك أن الدائرة لها مركز واحد ولها نقطة واحدة ولها وجود في ذاتها يقصد ويشار إليها فإن لم نجدها حسا أو لم يمكننا الإشارة إليها أمكننا أن نستخرجها ونقيم البرهان على أنها هي المركز دون غيرها من النقط. وأما النقط التي ليست بمركز فإنها لا نهاية لها ولا وجود لها بالذات وإنما توجد إذا فرضت فرضا وليست لها عين قائمة فلذلك لا تقصد ولا يمكن استخراجها لأنها مجهولة ولأنها شائعا في جميع الدائرة.
وأما الطرفان اللذان يسميان متضادين فهما موجودان معينان لأنهما طرفا خط مستقيم معين والبعد بينهما غاية البعد. مثال ذلك أنا إذا أخرجنا من مركز الدائرة خطا مستقيما إلى المحيط صار طرفاه محدودين أحدهما المركز والآخر نهايته عند المحيط والبعد بينهما غاية البعد. ومثاله من المحسوس البياض والسوادفان أحدهما يضاد الآخر وهما محدودان موجودان والبعد بين الضدين غاية البعد فأما التي بينهما فهي بلا نهاية وكذلك الألوان هي بلا نهاية. وأما أطراف الفضيلة فلما كانت أكثر من واحد لمتسم ضدا لأن لكل ضد ضدا واحدا ولا يمكن أن توجد أضداد كثيرة لضد واحد.
والسبب في ذلك أن البعد بينهما غاية البعد وقد نجد للفضيلة الواحدة أكثر من واحد.
وذلك
إذا تصورنا الفضيلة مركزا وأخرجنا منه خطا مستقيما فحصلت له نهاية أمكننا
أن نخرج من الجانب الآخر المقابل له خطا آخر على استقامته فتصير له نهاية
أخرى ويصيران جميعا مقابلين للمركز الذي فرضناه فضيلة إلا ان أحدهما يجري
مجرى الأفراط والغلو والآخر يجري مجرى التفريط والتقتير. وإذا قد فُهم ذلك
فليعلم أن لكل فضيلة طرفين محدودين يمكن الإشارة إليهما وأوساط بينهما
كثيرة لا نهاية لها ولا يمكن الإشارة إليها. إلا أن الوسط الحقيقي هو واحد
الذي سميناه فضيلة.
ثم ليعلم أننا بحسب هذا البيان نجعل أجناس الشرور
والرذائل ثمانية لأنها ضعف الفضائل الأربع التي تقدم شرحها وهي هذه:
التهور والجبن طرفان للوسط الذي هو الشجاعة. والشره والخمود طرفان للوسط
الذي هو العفة. والسفه والبله طرفان للوسط الذي هو الحكمة. والجور
والمهانة (أعني الظلم والإنظلام) طرفان للوسط الذي هو العدالة.
فهذه
أجناس الأمراض التي تقابل الفضائل التي هي صحة النفس وتحت هذه الأجناس
أنواع لا نهاية لها ونبدأ بذكر التهور والجبن اللذين هما طرفا الشجاعة وهي
فضيلة النفس وصحتها فنقول:
التهور والجبن
إن سببهما ومبدأهما النفس الغضبية ولذلك صارت الثلاثة بأسرها من علائق الغضب. والغضب في الحقيقة هو حركة للنفس يحدث بها غليان دم القلب شهوة للإنتقام. فإذا كانت هذه الحركة عنيفة أججت نار الغضب وأضرمتها فاحتد غليان دم القلب وامتلأت الشرايين والدماغ دخانا مظلما مضطربا يسوء منه حال العقل ويضعف فعله ويصير مثل الإنسان عند ذلك على ما حكته الحكماء مثل كهف ملىء حريقا وأضرم نارا فاختنق فيه اللهيب والدخان وعلا التأجج والصوت المسمى وحي النار فيصعب علاجه ويتعذر إطفاؤه ويصير كل ما يدنيه للإطفاء سببا لزيادته ومادة لقوته.فلذلك يعمى الإنسان عن الرشد ويصمعن الموعظة بل تصير المواعظ في تلك الحال سببا للزيادة في الغضب ومادة اللهب والتأجج وليس له في تلك الحال حيلة. وإنما يتفاوت الناس في ذلك بحسب المزاج حارا يابسا كان قريب الحال من حال الكبريت الذي إذا أدنيت منه الشرارة الضعيفة التهب، وإن كان بالضد فحاله بالضد وهذا في مبدأ أمره وعنفوان حركة الغضب به. فأما إذا احتدم فيكاد الحال يتقارب فيه وتصور ذلك من الحطب اليابس والرطب ومبدأ إشتعال النار بسرعة وشدة من الكبريت والنقط. ثم انحدر منهما إلى الإدهان المتوسطة إلى أن تنتهي إلى الإحتكاك فإن الإحتكاك وإن كان ضعيفا في توليد النار فربما قوى حتى تلتهب منه الإجمة العظيمة. وكفاك مثل السحاب الذي هو من البخارين كيف يحتك حتى تنقدح بينهما النيران وينزل منهما الصواعق التي لا يثبت أثرها شيء من المواد ولا يفارق ما يتعلق به حتى يصير رميما وإن كان جبلا أطلسا وحجرا أصم.
وأما بقراطس فإنه قال إني للسفينة إذا عصفت الرياح وتلاطمت عليها الأمواج وقذفت بها إلى اللجج التي كالجبال أرجى مني للغضبان الملتهب.
وذلك أن السفينة في تلك الحال يلطف لها الملاحون ويخلصونها بضروب الحيل وأما النفس إذا استشاطت غضبا فليس يرجى لها حيلة ألبتة.
وذلك أن كل ما رجة به الضغب من التضرع والمواعظ والخضوع يصير له بمنزلة الجزل من الحطب يوهجه ويزيده إشتعالا. أما أسبابه المولدة له فيه العجب. والإفتخار. والمراء. واللجاج. والمزاح. والتيه. والإستهزاء. والغدر. والضيم. وطلب الأمور التي فيها لذة ويتنافس فيها الناس ويتحاسدون عليها. وشهوة الإنتقام غاية لجميعها لأنها بأجمعها تنتهي إليه ومن لواحقه الندامة وتوقع المجازاة بالعقاب عاجلا وآجلا وتغير المزاج وتعجل الألم. وذلك أن الغضب جنون ساعة وربما أدى إلى التلف بإختناق لحرارة القلب وربما كان سببا لأمراض صعبة مؤدية إلى التلف. ثم من لواحقه مقت الأصدقاء وشماتة الأعداء وإستهزاء الحساد والأردال من الناس. ولكل واحد من هذه الأسباب وإماطتها فقد أوهنا قوة الغضب وقطعنا مادتها وأمنا غائلتها. فإن عرض لنا منها عارض كان بحيث نطيع العقل ونلتزم شرائطه وحدثت فضيلته أعني الشجاعة فيكون حينئذ أقدامنا على ما نقدم عليه كما يجب وبحيث يجب وبالمقدار الذي يجب وعلى من يحب.
العجب والإفتخار
أما العجب فحقيقته إذا حددناه أنه ظن
كاذب بالنفس في استحقاق مرتبة هي غير مستحقة لها. وحقيق على من عرف نفسه
أن يعرف كثرة العيوب والنقائص التي تعتورها فإن الفضل مقسوم بين البشر
وليس يكمل الواحد منهم إلا بفضائل غيره. وكل من كانت فضيلته عند غيره
فواجب عليه أن لا يعجب بنفسه. وكذلك الإفتخار فإن الفخر هو المباهات
بالأشياء الخارجة عنا ومن باهي بما هوخارج عنه فقد باهى بمالا يملكه. وكيف
يملك ما هو معرض للآفات والزوال في كل ساعة وفي كل لحظة ولسنا على ثقة منه
في شيء من الأوقات وأصح الأمثال وأصدقها فيه ما قاله الله عز وجل:
(وَاضرِب لَهُم مَثلاٌ رَجُلَين جَعَلنا لأَحَدِهِما جَنَتينِ مِن
أَعنابٍ) إلى قوله: (فَأَصبَحَ يُقَلِبُ كَفَيهِ عَلى ما أَنفَقَ فيها
وَهيَ خاوِيةٌ عَلى عُرُوشِها) وقال تعالى: (وَاضرِب لَهُم مَثَلَ
الحَياةِ الدُنيا كَمَاءٍ أَنزَلَناهُ مِنَ السَماءِ فاختلَطَ بِهِ نَباتُ
الأَرضِ فَأَصبَحَ هَشيماً تَذرُوهُ الرِياح وَكانَ الله عَلى كُلِ شَيءٍ
مُقتَدِراً) وفي القرآن من هذه الأمثال شيء كثير وكذلك في الأخبار المروية
عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المفتخر بنسبة فأكثر ما يدعيه إذا كان
صادقا أن أباه كان فاضلا فلو حضر ذلك الفاضل وقال أن الفضل الذي تدعيه لي
أنا مستبد به دونك فما الذي عندك منه مما ليس عند غيرك لأفحمه وأسكته.
وقد
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أخبار كثيرة صحيحة
منها أنه قال: (لا تأتوني بأنسابكم وائتوني بأعمالكم) أو ما هذا معناه.
ويحكى عن مملوك كان لبعض الفلاسفة أنه افتخر عليه بعض رؤساء زمانه فقال له
إن افتخرت علىَّ بفرسك فالحسن والفراهة للفرس لا لك. وإن افتخرت بثيابك
وآلاتك فالحسن لها دونك. وإن افتخرت بآبائك فالفضل كان فيهم دونك. فإذا
كانت الفضائل والمحاسن خارجة عنك وأنت منسلخ عنها وقد رددناها على أصحابها
بل لم تخرج عنهم فترد عليهم وأنت ممن يحقق ذلك إن شاء الله تعالى. وحكي عن
بعض الفلاسفة أنه دخل على بعض أهل اليسار والثروة وكان يحتشد في الزينة
ويفتخر بكثرة آلاته وقد حضرت الفيلسوف بصقة فتنخع لها والتفت في البيت
يمينا وشمالا ثم بصق في وجه صاحب البيت فلما عوتب على ذلك قال: (إني نظرت
إلى البيت وجميع ما فيه فلم أجد هناك أقبح منه فبصقت عليه) وهكذا يستحق من
كان خاليا من فصائل نفسه وافتخر بالخارجات عنه.
فأما المراء واللجاج. فقد ذكرنا قبح صورتهما في المقالة التي قبل هذه وما يولدانه من الشتات والفرقة والتباغض بين الإخوان.
المزاح والتيه والإستهزاء
وأما المزاح فإن المعتدل منه محمود وكان رسول الله صلى الله عليه يمزح ولا يقول غلا حقا. وكان أمير المؤمنين كثير المزاح حتى عابه بعض الناس فقال لولا دعاية فيه. ولكن الوقوف على المقدار المعتدل منه صعب وأكثر الناس يبتدىء ولا يدري أين يقف منه فيخرج عن حده ويروم الزيادة فيه على صاحبه حتى يصير سببا للوحشة فيثير غضبا كامنا ويزرع حقدا باقيا فلذلك عددناه في الأسباب فينبغي أن يحذره من لا يعرف حده ويذكر قول القائل:رب جد جره اللعب ... وبعض الحرب أوله مزاح
ثم يهيج فتنة لا يهتدي لعلاجها. وأما التيه فهو قريب من العجب والفرق بينهما أن المعجب يكذب نفسه فيما يظن لها والتياه يتيه على غيره ولا يكذب نفسه غلا أن علاجه علاج المعجب بنفسه. وذلك بأن يعرف أن ما يتيه به لا مقدار له عند العقلاء وأنهم لا يعتدون به لخساسة قدره ونزارة حظه من السعادة ولأنه متغير زائل غير موثوق ببقاءه ولأن المال والأثاث وسائر الأعراض قد توجد عند كل صنف من الناس الأراذل والأشراف والجهال.
فأما الحكمة فليست توجد إلا عند الحكماء خاصة. وأما الإستهزاء فإنه يستعمله المجّان من الناس والمساخر ومن لا يبالي بما يقابل به لأنه قد وضع في نفسه إحتمال مثل ذلك وإضعافه فهو ضاحك قرير العين بضروب الإستخفافات التي تلحقه وإنما يتعيش بالدخول تحت المذلة والصغار بل إنما يتعرض بقليل ما يبتدىء به لكثير ما يعامل به ليضحك غيره وينال اليسير من بره. والحر الفاضل بعيد من هذا المقام جدا لأنه يكرم نفسه وعرضه عن تعريضهما للسفها وبيعهما بجميع خزائن الملوك فضلا عن الحقير التافه.
الغدر والضيم
وأما الغدر
فوجوهه كثيرة اعني أنه يستعمل في المال وفي الجاه وفي الحرم وفي المودة
وهو على كثرة وجوهه مذموم بكل لسان ومعيب عند كل أحد ينفر السماع من ذكره
ولا يعترف به إنسان وإن قل حظه من الإنسانية وليس يوجد غلا في جنس من
أجناس العبيد فيتوقاهم الناس ويأنف منهم سائر أجناس العبيد.
ذلك أن
الوفاء الذي هو ضده موجود في جنس الحبشة والروم والنوبة وقد شاهدنا من حسن
وفاء كثير من العبيد ما لم نشاهده في كثير من المتسمين بالأحرار. ومن عرف
قبح الغدر باسمه ونفور العقلاء منه ثم عرف معناه فليس يستعمله وبالأخص من
له طبيعة جيدة أو قرأ ما تقم في هذا الكتاب وتخلق به وانتهى في قراءته إلى
هذا الموضع. وأما الضيم فهو تكليف إحتمال الظلم والغضب وربما يعرض منه
شهوة الإنتقام وقد ذكرنا فيما تقدم الظلم والإنظلام وشرحنا الحال فيهما.
فيبنبغي
أن لا نسرع إلى الإنتقام عند ضيم يلحقنا حتى ننظر فيه ونحذر أن لا يعود
علينا الإنتقام بضرر أعظم من إحتمال ذلك الضيم. وهذا النظر والحذر هو
استشارة العقل وهو الحلم بعينه.
المقتنيات والجواهر النفيسة
وأما طلب الأمور التي فيها عزة وتتنافس فيها الناس فهو خطأ من الملوك والعظماء فضلا عن أوساط الناس. وذلك أن الملك إذا حصل في خزانته علق كريم أو جوهر نفيس فهو متعرض به للجزع عند فقده ولا بد من حلول الآفات به لما عليه طبيعة عالم الكون والفساد من تغيير الأمور وإحالتها وإدخال الفساد على كل ما يدخر ويقتني. فإذا فقد الملك ذخيرة عزيزة الوجود ظهر عليه ما يظهر على المفجوع المصاب بما يعز عليه وتبين فقره إلى نظيره الذي لا يجده فيطلع الصديق والعدو على حزنه وكآبته.وحكى عن بعض الملوك أنه أهدى إليه قبة بلور صافية عجيبة النقاء والصفاء محكمة الخرط قد استخرج منها أساطين وصور خاطر بها صانعها مرة بعد مرة في تلخيص النقوش والخروق والتجاويف التي بين الصور والأوراق فلما حصلت بين يديه كثر عجبه منها وإعجابه بها وأمر فرفعت في خاص خزائنه فلم يأت عليها كثير زمان حتى أصابها ما يصيب أمثالها من المتالف وبلغ الملك ذلك فظهر عليه من الأسف والجزع ما منعه من التصرف في أموره والنظر في مهماته والجلوس لجنده وحاشيته واجتهد الناس في وجود شيء شبيه بها فتعذر عليهم فظهر أيضا من عجزه وامتناع مطلوبه عليه ما تضاف به جزعه وحزنه.
وأما أوساط الناس فإنهم متى أدخروا آلة كريمة أو جوهرا نفيسا أو اتخذوا مركوبا فارها أو ما أشبه هذه الشياء التمسها منه من لا يمكنه رده عنها فإن حجزه عنها وبخل عليه بها فقد عرض نفسه ونعمته للبوار.
وإن سمح بها لحقه من الغم والجزع ما كان مستغنيا عنه.
وأما الأحجار المتنافس فيها من اليواقيت وأشباهها مما تبعد عنها الآفات في أنفسها فليس تبعد عنها الآفات الخارجة عنها من السرقة ووجوه الحيل فيها وإذا أدخرها الملك قل انتفاعه بها عند حاجته إليها وربما عدم الإنتفاع بها دفعة.
ذلك أنه إذا اضطر إليها لم تنفعه في عاجل أمره وحاضر ضرورة الملك. وقد شاهدنا أعظم الملوك خطرا في عصرنا لما احتاج إليها بعد فناء أموال ونفاد ما في خزائنه وقلاعه لم يجد ثمنها ولا قريبا من ثمنها عند أحد ولم يتحصل منها غلا على الفضيحة في حاجته إلى رعيته في بعض قيمتها وهو لا يقدر على قليل ولا كثير من أثمانها وهي مبذولة مبتذلة في أيدي الدلاين والتجار والسوقة يتعجبون منها ولا يقدرون عليها. ومن قدر منهم على ثمن شيء منها لم يتجاسر عليها خوفا من تتبعه بعد ذلك وظهور أمرة وإنتزاعها منه.
فهذه حال هذه الذخائر عند الملوك. أما التجار الموسومون بهذه الصناعة فربما اتفق لهم زمان صلاح وسكون من الرؤساء وأمن في السرب وحينئذ تكون بضاعتهم شبيهة بالكاسدة لأنها لا تنفق إلا على الملوك الودعين الذين لا يحزمنهم شيء من نوائب الدهر وقد استمر بهم الخفض وفضلت أموالهم عن الخزائن والقلاع فحينئذ يغترون بالزمان فيقعون في مثل هذه الخدائع ثم تؤول عاقبتهم إلى ما حذرنا منه.
أسباب الغضب
فهذه أسباب الغضب والأمراض الحادثة
منها ومن عرف العدالة وتخلق بها كما قدمناه فيما تقدم سهل عليه علاج هذا
المرض لأنه جورو خروج عن الإعتدال. ولذلك لا ينبغي أن نسميه بأسماء
المديح. وأعني بذلك أن قوما يسمون هذا النوع من الجور أعني الغضب في غير
موضعه رجزلية وشدة شكيمة ويذهبون به مذهب الشجاعة التي هي بالحقيقة اسم
للمدح وشتان ما بين المذهبين. فإن صاحب هذا الخلق الذي ذممناه تصدر عنه
أفعال رديئة كثيرة يجور فيها على نفسه ثم على إخوانه ثمعلى الأقرب فالأقرب
من معامليه حتى ينتهي إلى عبيده وإلى حرمه فيكون عليهم سوط عذاب ولا
يقيلهم عثرة ولا يرحم لهم عبرة وإن كانوا برآء من الذنوب غير مجترمين ولا
مكتسبين سواء بل يتجرم عليهم ويهيج من أدنى سبب يجد به طريقا إليهم حتى
يبسط لسانه ويده وهم لا يمتنعون منه ولا يتجاسرون على رده عن أنفسهم بل
يذعنون له ويقرون بذنوب لم يقترفوها إستكفافا لشره وتسكينا لغضبه وهو مع
ذلك مستمر على طريقته لا يكف يدا ولا لسانا وربما تجاوز في هذه المعاملة
الناس إلى البهائم التي لا تعقل وإلى الأواني التي لا تحس. فإن صاحب
هذاالخلق الردىء ربما قام إلى الحمار والبرذون أو إلى الحمار والعصفور
فيتناولها بالضرر والمكروه وربما عض القفل إذا تعسر عليه وكسر الآنية التي
لا يجد فيها طاعة لأمره.
وهذا النوع من رداءة الخلق مشهور في كثير من
الجهال يستعملونه في الثوب والزجاج والحديد وسائر الآلات، أماالملوك من
هذه الطائفة فإنهم يغضبون على الهواء إذا هب مخالفا لهواهم وعلى القلم إذا
لم يجر على رضاهم فيسبون ذاك ويكسرون هذا. وكان بعض من تقدم عهده من
الملوك يغضب على البحر إذا تأخرت سفينة فيه لاضطرابه وحركة الأمواج حتى
يهدهه بطرح الجبال فيه وطمّه بها. وكان بعض السفهاء في عصرنا بغضب على
القمر ويسبه ويهجوه بشعر له مشهور. وذلك أنه كان يتأذى به إذا نام فيه.
وهذه
الأفعال كلها قبيحة وبعضها مع قبحه مضحك يهزأ بصاحبه. فكيف يمدح بالرجولية
والشدة وشرف النفس وعزتها وهي بالمذمة والفضيحة أولى منها بالمديح؟ وأي حظ
لها في العزة والشدة ونحن نجدها في النساء أكثر منها في الرجال وفي المرضى
أقوى منها في الأصحاء ونجد الصبيان أسرع غضبا وضجرا من الرجال.
والشيوخ
أكثر من الشبان ونجد رذيلة الشره. فإن الشره إذا تعذر عليه ما يشتهيه غضب
وشجر على من يهىء طعامه وشرابه من نسائه وأولاده وخدمه وسائر من يلابس
أمره. والبخيل إذا فقد شيئا من ماله تسرع بالغضب على أصدقائه ومخالطيه
وتوجهت تهمته إلى أهل الثقة من خدمه ومواليه. وهؤلاء الطبقة لا يحصلون من
أخلاقهم إلا على فقد الصديق وعدم النصيح وعلى الذم السريع واللوم الوجيع.
وهذه حال لا تتم معها غبطة ولا سرور وصاحبها أبدا محزون كئيب متنغص بعيشه متبرم بأموره وهي حال الشقي المحروم.
أما
الشجاع العزيز النفس فهوالذي يقهر بحلمه غضبه ويتمكن من التمييز والنظر
فيما يدهم ولا يستفزه ما يرد عليه من المحركات لغضبه حتى يتورى وينظر كيف
ينتقم ممن وعلى أي قدر. وكيف يصفح ويغضي عمن وفي أي ذنب. حكي عن الإسكندر
أنه نمى إليه عن بعض أصحابه أنه يعيبه وينتقصه فقال له بعض أصحابه لو
أدبته أيهاالملك بعقوبة تنهكه بها.
فقال له وكيف يكون انهاكه بعد عقوبتي إياه في ثلبي وطلب معايب لأنه حيئنذ أبسط لسانا وأعذر عند الناس.
وأتى
يوما ببعض أعدائه من المتغلبين الخارجين عليه وكان قد عاث في أطرافه بلاده
عيثا كثيرا فصفح عنه، فقال له بعض جلسائه: لو كنت أنا أنت لقتلته. فقال له
الإسكندر ولكن لم أكن أنا أنت فلست بقاتله.
فقد ذكر معظم أسباب
الغضب ودللنا على معالجتها وحسمها وهو النوع الأعظم من أمراض النفس وإذا
تقدم الإنسان في حسم سببه لم يخش تمكنه منه، وكان ما يعرض له سهل العلاج
قريب الزوال لا مادة له تلهبه وتمده ولأسباب يسعره ويوقده. وتجد الروية
موضعا لإجالة النظر والفكر في فضيلة الحلم وإستعمال المكافأة إن كان صوابا
أوالتغافل إن كان حزما. والذي يتلو معالجة هذا من أمراض النفس معالجة
الجبن الذي هو الطرف الآخر من صحتها. ولما كانت الأضداد يعرف بعضها من بعض
وقد عرفنا الطرف الذي حددناه بحركة للنفس عنيفة قوية يحدث منها غليان دم
القلب شهوة للإنتقام فقد عرفنا إذا مقابله أعني الطرف الآخر الذي هو سكون
للنفس عندما يجب أن تتحرك فيه وبطلان شهوة الإنتقام وهذا هو سبب الجبن
والخور.
الجبن والخور
وتتبعهما إهانة النفس وسوء العيش وطمع طبقات الأنذال وغيرهم من الأهل والأولاد والمعاملين وقلة الثبات والصبر في المواطن التي يجب فيها الثبات وهما أيضا سبب الكسل ومحبة الراحة اللذين هما سببا كل رذيلة ومن لواحقهما الإستحذاء لكل أحد والرضى بكل رذيلة وضيم. والدخول تحت كل فضيحة في النفس والأهل والمال وسماع كل قبيحة فاحشة من الشتم والقذف وإحتمال كل ظلم من كل معامل وقلة الأنفة مما يأنف منه الناس. وعلاج هذه الأسباب واللواحق يكون بأضدادها.وذلك بأن توقظ النفس التي تمرض هذا المرض بالهز والتحريك. فإن الإنسان لا يخلو من القوة الغضبية رأسا حتى تجلب إليه من مكان آخر ولكنها تكون ناقصة عن الواجب فهي بمنزلة النار الخامدة التي فيها بقية لقبول الترويح والنفخ فهي تتحرك لا محالة إذا حركت بما يلائمها وتبعث ما في طبيعتها من التوقد والتلهب. وقد حكي عن بعض المتفلسفين أنه كان يتعمد مواطن الخوف فيقف فيها ويحمل نفسه على المخاطرات العظيمة بالتعرض لها ويركب البحر عند اضطرابه وهيجانه ليعود نفسه الثبات في المخاوف ويحرك منها القوة التي تسكن عند الحاجة إلى حركتها ويخرجها عن رذيلة الكسل ولواحقه ولا يكره لمثل صاحب هذا المرض بعض المراء والتعرض للملاحاة وخصومة من يأمن غائلته حتى يقرب من الفضيلة التي هي وسط بين الرذيلتين أعني الشجاعة التي هي صحة النفس المطلوبة فإذا وجدها وأحس بها من نفسه كف ووقف ولم يتجاوزها حذرا من الوقوع في الجانب الآخر الذي علمناك علاجه.الخوف وأسبابه وعلاجهولما كان الخوف الشديد غير موضعه من أمراض النفس وكان متصلا بهذه القوة وجب أن نذكره ونذكر أسبابه وعلاجه فنقول: إن الخوف يعرض من توقع مكروه وانتظار محذور والتوقع والإنتظار إنما يكونان للحوادث في الزمان المستقبل.
وهذه الحوادث ربما كانت عظيمة وربما كانت يسيرة وربما كانت ضرورية وربماكانت ممكنة، والأمور الممكنة ربما كنا نحن أسبابها وربما كان غيرنا سببها وجميع هذه الأقسام لا ينبغي للعاقل أن يخاف منها.
أما الأمور الممكنة فهي بالجملة مترددة بين أن تكون وبين أن لا تكون ولا يجب أن يصمم على أنها تكون فيستشعر الخوف منها ويتعجل مكروه التألم بها وهي لم تقع بعد ولعلها لا تقع وقد أحسن الشاعر في قوله:
وقل للفؤاد أن ترى بك نزوة ... من الروع أفرج أكثر الروع باطله
فهذه حال ما كان منها عن سبب خارج وقد أعلمناك أنها ليست من الواجبات التي لا بد من وقوعها. وما كان كذلك فالخوف من مكروهه يجب أن يكون على قدر حدوثة. وإنما يحسن العيش وتطيب الحياة بالظن الجميل والأمل القوي وترك الفكر في كل ما يمكن أن لا يقع من المكاره وأما ما كان سببه سوء اختيارنا وجنايتنا على أنفسنا فينبغي أن نحترز منه بترك الذنوب والجنايات التي نخاف عواقبها ولا نقدم على أمر لا تؤمن غائلته فإن هذا فعل من نسى أن الممكن هو الذي يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون.
وذلك أنه إذا أتى ذنبا أو جنى جناية قدر
في نفسه أنه يخفى ولا يظهر أو لا يخفى فيظهر إلا أنه يتجاوز عنه أولا تكون
له غائلة. وكأنه يجعل طبيعة الممكن واجبا كما أن صاحب القسم الأول يجعل
أيضا الممكن واجبا إلا أن هذا يأمن الجانب المحذور خاصة وأعني بهذا أن
الممكن لما كان متوسطا بين الجانب الواجب والجانب الممتنع صار كالشيء الذي
له جهتان إحداهما تلي الواجب والأخرى تلي الممتنع. ومثال ذلك خط ا ج ب
فنقطة ا هي الجانب الواجب. ونقطة ب هي الجانب الممتنع. وموضع ج هوالممكن
وبعده من الجانبين بعد واحد. فله إلى نقطة (1) جهة. وله إلى نقطة (ب) جهة.
فإذا صار مستقبله ماضيا بطل إسم الممكن عنه وحصل إما في جانب الواجب وأما
في جانب الممتنع وليس يصح ما دام ممكنا أن يحسب لا من من هذا الجانب ولا
من ذاك الجانب بل يعتقد فيه طبيعته الخاصة به وهو أنه يمكن أن يصير إلى
ههنا أو إلى هناك. ولهذا قال الحكيم وجوه الأمور الممكنة في أعقابها. وأما
الأمور الضرورية كالهرم وتوابعه فعلاج الخوف منه أن نعلم أن الإنسان إذا
حب طول الحياة فقد أحب لا محالة الهرم واستشعره إستشعار ما لا بد منه. ومع
الهرم يحدث نقصان الحرارة الغريزية والرطوبة الأصلية التابعة لها وغلبة
ضديهما من البرد واليبس وضعف الأعضاء الأصلية كلها. ويتبع ذلك قلة الحركة
وبطلان النشاط وضعف آلات الهضم وسقوط آلات الطحن ونقصان القوى المدبرة
للحيا، أعني القوة الجاذبة والقوة الممسكة والهاضمة والدافعة وسائر ما
يتبعها من مواد الحيابة. وليست الأمراض والآلام شيأ غير هذه الأشيأ ثم
يتبع ذلك موت الأحياء وفقد الأعزاء والمستشعر لهذه الأشياء الملتزم
لشرائطها في مبدأ كونه لا يخاف منها بل ينتظرها ويرجوها ويدعي له بها
ويرغب إلى الله فيها.
فهذه جملة الكلام على الخوف المطلق ولما كان أعظم
ما يلحق الإنسان منه هو خوف الموت وكان هذا الخوف عاما وهو مع عمومه أشد
وأبلغ من جميع المخاوف وجب أن نبدأ بالكلام فيه فنقول:
علاج الخوف من الموت
إن الخوف من الموت ليس يعرض إلا لمن لا يدري ما الموت على الحقيقة أولا يعلم إلى أين تصير نفسه أو لأنه يظن أن بدنه إذا انحل وبطل تركيبه فقد انحلت ذاته وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور وأن العالم سيبقى موجود أو ليس هو بموجود فيه كما يظنه من يجهل بقاء النفس وكيفية المعاد. أو لأنه يظن أن للموت ألما عظيما غير ألم لأمراض التي ربما تقدمته وأدت إليه وكانت سبب حلوله أو لأنه يعتقد عقوبة تحل به بعد الموت. أو لأنه متحير لا يدري على أي شيء يقدم بعد الموت. أو لأنه يأسف على ما يخلفه من المال والمقتنيات وهذه كلها ظنون باطلة لا حقيقة لها. أما من جهل الموت ولا يدري ماهو على الحقيقة فإنا نبين له أن الموت ليس بشيء أكثر من ترك النفس استعمال آلاتها وهي الأعضاء التي يسمى مجموعها بدنا كما يترك الصانع إستعمال آلاته. وأن النفس جوهر غير جسامني وليست عرضا وإنها غير قابلة للفساد وهذا البيان يحتاج فيه إلى علوم تتقدمه وهو مبرهن مشروح على الإستقصاء في موضعه الخاص به. من تطلع إليه ونشط للوقوف عليه لم يبعد مرامه ومن قع بما ذكرته في صدر هذا الكتاب وسكنت نفسه إليه علم أن ذلك الجوهر مفارق لجوهر البدن مباين له كل المبانية بذاته وخواصه وأفعاله وآثاره فإذا فارق البدن كما قلنا وعلى الشريطة التي شرطنا بها البقاء الذي يخصه ونقى من كدر الطبيعة وسعد السعادة التامة ولا سبيل إلى فنائه وعدمه.فإن الجوهر لا يفنى من حيث هو جوهر ولا تبطل ذاته وإنما تبطل الأعراض والنسب والإضافات التي بينه وبين الأجسام بأضدادها. فأما الجوهر فلا شد له ولك شيء يفسد فإنما فساده من ضده وقد يمكنك أن تقف على ذلك بسهولة من أوائل المنطق قبل أن تصل إلى براهينه.
وإن أنت تأملت الجوهر الجسماني الذي أخس من ذلك الجوهر الكريم
واستقرت حاله وجدته غير فإن ولامتلاش من حيث هو جوهر إنما يستحيل بعضه إلى
بعض فتبطل خواصه شيئا فشيئا منه وأعراضه. فأما الجوهر نفسه فهو باق لا
سبيل إلى عدمه وبطلانه. مثال ذلك الماء فإنه يستحيل بخارا وهواء وكذلك
الهواء يستحيل ماء ونارا فتبطل عن لجوهر أعراضه وخواصه وأما الجوهر من حيث
هو جوهر فإنه لا سبيل إلى عدمه هذا في الجوهر الجسماني القابل للإستحالة
والتغير. فأما الجوهر الروحاني الذي لا يقبل الإستحالة ولا التغير في ذاته
وإنما يقبل كمالاته وتمامات صورة فكيف يتوهم فيه العدم والتلاشي. وأما من
يخاف الموت لأنه لا يعلم إلى أين تصير نفسه أو لأنه يظن أن بدنه إذا انحل
وبطل تركيبه فقد انحلت ذاته وبطلت نفسه وجهل بقاء النفس وكيفية المعاد
فليس يخاف الموت على الحقيقة وإنما يجهل ما ينبغي أن يعلمه. فالجهل إذا هو
المخوف إذ هو سبب الخوف. وهذا الجهل هو الذي حمل الحكماء على طلب العلم
والتعب به وتركوا لأجله اللذات الجسمانية وراحات البدن وأختاروا عليه
النصب والسهر ورأوا أن الراحة التي تكون من الجهل هي الراحة الحقيقية. وأن
التعب الحقيقي هو تعب الجهل لأنه مرض مزمن للنفس والبرء منه خلاص لها
وراحة سرمدية ولذة أبدية. ولما تيقن الحكماء ذلك وأستبصروا فيه وهجموا على
حقيقته ووصلوا إلى الروح والراحة منه هانت عليهم أمور الدنيا كلها
واستحقروا جميع ما يستعظمه الجمهور من المال والثروة واللذات الحسية
والمطالب التي تؤدي غليها إذ كانت قليلة الثبات والبقاء سريعة الزوال
والفناء كثيرة الهموم إذا وجدت. عظيمة الغموم إذ فقدت. واقتصروا منها على
المقدار الضروري في الحياة وتسلوا عن فضول العيش الذي فيه ما ذكرت من
العيوب وما لم أذكره ولأنها مع ذلك بلا نهاية ذلك أن الإنسان إذا بلغ منها
إلى غاية تاقت نفسه إلى غاية أخرى منغير وقوف على حد ولا إنتهاء إلى
الأمد. وهذا هو الموت لا ما يخاف منه والحرص عليه هو الحرص على الزائل
والشغل به هو الشغل بالباطل. ولذلك جزم الحكماء بأن الموت موتان موت إرادي
وموت طبيعي.
وكذلك الحياة حياتان حياة إرادية وحياة طبيعية وعنوا
بالموت الإرادي إماتة الشهوات وترك التعرض لها وبالموت الطبيعي مفارقة
النفس البدن.
وعنوا بالحياة الإرادية ما يسعى له الإنسان لحياته الدنيا
من المآكل والمشارب والشهوات. وبالحياة الطبيعية بقاء النفس السرمدي بما
تستفيده من العلوم الحقيقية وتبرأ به من الجهل. ولذلك وصى أفلاطون طالب
الحكمة بأن قال له مت بالإرادة تحي بالطبيعة. على أن من خاف الموت الطبيعي
للإنسان فقد خاف ما ينبغي أن يرجوه. ذلك أن هذا الموت هو تمام حد الإنسان
لأنه حي ناطق ميت. فالموت تمامه وكما له وبه يصير إلى أفقه الأعلى. ومن
علم أن كل شيء هو مركب من حد وحدّه مركب من جنسه وفصوله. وأن جنس الإنسان
هو الحي وفصلاه الناطق والمايت علم أنه سينحل إلى جنسه وفصوله لأن مركب لا
محالة منحل إلى ما تركب منه. فمن أجهل ممن يخاف تمام ذاته ومن أسوء حالا
ممن يظن أن فناءه بحياته ونقصانه بتمامه.
ذلك أن لاناقص إذا خاف أن يتم
فقد دل من نفسه على غاية الجهل. فإذا الواجب على العاقل أن يستوحش من
النقصان ويأنس بالتمام ويطلب كل ما يتممه ويكمله ويشرفه ويعلى منزلته
ويخلي رباطه من الوجه الذي يأمن به الوقوع في الأسر لا من الوجه الذي يشدو
وثاقه ويزيده تركيبا وتعقيدا ويثق بأن الجوهر الشريف الإلهي إذا تخلص من
الجوهر الكثيف الجسماني خلاص بقاء وصفو لاخلاص مزاج وكدر فقد سعد وعاد إلى
ملكوته وقرب من بارئه وفاز بجوار رب العالمين وخالط الأرواح الطيبة من
أشكاله وأشباهه ونجا من أضداده وأغياره، ومن ههنا يعلم أن من فارقت نفسه
بدنه وهي مشتاقة إليه مشفقة عليه خائفة من فراقه فهي في غاية الشقاء
والبعد من ذاتها وجوهرها سالكة إلى أبعد جهاتها من مستقرها طالبة قرار ما
لا قرار له. أما من ظن أن للموت ألما عظيما غير ألم الأمراض التي ربما
اتفق أن تتقدم الموت وتؤدي إليه فعلاجه أن يبين له أن هذا ظن كاذب لأن
الألم إنما يكون للحيّ والحي هو القابل أثر النفس.
وأما الجسم الذي
ليس فيهأثر النفس فإنه لا يألم ولا يحس فإذا الموت الذي هو مفارقة النفس
البدن لا ألم له لأن البدن إنما كان يألم ويحس بأثر النفس فيه فإذا صار
جسما لا أثر فيه للنفس فلا حس له ولا ألم.
فقد تبين أن الموت حال للبدن
غير محسوس عنده ولا مؤلم لأنه فراق ما به كان يحس ويتألم فأما من خاف
الموت لأجل العقاب الذي يوعد به بعد. فينبغي أن نبين له أنه ليس يخاف
الموت بل يخاف العقاب والعقاب إنما يكون على شيء باق بعد البدن الدائر.
ومن اعترف بشيء باق منه بعد البدن وهو لا محالة معترف بذنوب له وأفعال
سيئة يستحق عليها العقاب ومع ذلك هو معترف بحاكم عدل يعاقب على السيئات لا
على الحسنات فهو إذا خائف من ذنوبه لا من الموت.
ومن خاف عقوبة على ذنب فالواجب عليه أن يحذر ذلك الذنب ويجتنبه.
وقد
بينا فيما تقدم أن الأفعال الرديئة التي تسمى ذنوبا إنما تصدر عن هيئات
رديئة والهئيات هي للنفس وهي الرذائل التي أحصيناها وعرفناك أضدادها من
الفضائل. فإذا الخائف من الموت على هذه الطريقة ومن هذه الجهة جاهل بما
ينبغي أن يخاف منه وخائف بما لا أثر له ولا خوف منه وعلاج الجهل هو العلم
فإذا الحكمة هي التي تخلصنا من هذه الآلام والظنون الكاذبة التي هي نتائج
الجهالات والله الموفق لما فيه الخير، وكذلك نقول لمن خاف الموت لأنه لا
يدري على ما يقدم بعد الموت لأن هذه حال الجاهل الذي يخاف بجهله فعلاجه أن
يتعلم ليعلم ويشتاق.
وذلك ان من أثبت لنفسه حالا بعد الموت ثم لم يعلم
ما هي تلك الحال فقد أقر بالجهل وعلاج الجهل العلم. ومن علم فقد وثق ومن
وثق فقد عرف سبيل السعادة فهو يسلكها لا محالة ومن سلك طريقا مستقيما إلى
غرض صحيح أفضى إليه بلا شك ولا مرية. وهذه الثقة التي تكون بالعلم هي
اليقين وهي حال المستبصر في دينه المستمسك بحكمته وقد عرفناك مرتبته
ومقامه فيما سلف من القول، اما من زعم أنه ليس يخاف الموت وإنما يحزن على
ما يخلف من أهله وولده وماله ونشبه ويأسف على ما يفوته من ملاذ الدنيا
وشهواتها.
فينبغي أن نبين له أن الحزن تعجل ألم ومكروه على ما لا
يجدي الحزن إليه بطائل وسنذكر علاج الحزن في باب مفرد له خاص لأنا في هذا
الباب إنما نذكر علاج الخوف وقد أتينا منه على ما فيه مقتنع وكفاية إلا
أنا نزيده بيانا ووضوحا فنقول: أن الإنسان من جملة الأمور الكائنة وقد
تبين في الآراء الفلسفية أن كل كائن فاسد لا محالة فمن أحب أن لا يفسد فقد
أحب أن لا يكون. ومن أحب أن لا يكون فقد أحب فساد ذاته فكأنه يحب أن يفسد
ويحب أن لا يفسد ويحب أن يكون ويحب أن لا يكون وهذا محال لا يخطر ببال
عاقل. وأيضا فإنه لو لم يمت أسلافنا وآباؤنا لم ينته الوجود إلينا ولو جاز
أن يبقى الإنسان لبقي من تقدمنا ولو بقي من تقدمنا من الناس على ما هم
عليه من التناسل ولم يموتوا لما وسعتهم الأرض. وأنت تتبين ذلك مما أقول.
هب أن رجلا واحدا ممن كان منذ أربعمائة سنة هو موجود الآن وليكن من مشاهير
الناس حتى يمكن أن يحصل أولاده موجودين معروفين كعلي بن أبي طالب كرم الله
وجهه مثلا. تم ولد له اولاد ولأولاده أولاد وبقوا كذلك يتناسلون ولا يموت
منهم أحد. كم يكون مقدار من يجتمع منهم في وقتنا فإنك تجدهم أكثر من عشرة
آلاف ألف رجل وذلك أن بقيتهم الآن مع ما قدر فيهم من الموت والقتل الذريع
أكثر من مائة ألف نسمة في جميع الأرض وأحسب لمن كان في ذلك العصر من الناس
على بسيد الأرض مثل هذا الحساب فإنهم إذا تضاعفوا هذا التضاعف لم تضبطهم
كثرة ولم تحصهم عددا. ثم امسح بسيط الأرض فإنه محدود معروف لتعلم أن الأرض
حينئذ لا تسعهم قياما فكيف قعودا أومنصرفين ولا يبقى موضع عمارة يفضل عنهم
ولا مكان رزاعة ولا مسير لأحد ولا حركة فضلا عن غيرها وهذه مدة يسيرة من
الزمان فكيف إذا امتد الزمان وتضاعف الناس على هذه النسبة. فهذه حال من
يتمنى الحياة الأبدية للبدن ويكره الموت ويظن أن ذلك ممكن أو مطموع فيه من
الجهل والغباوة فإذا الحكمة البالغة والعدل المبسوط بالتدبير الإلهي هو
الصواب الذي لا معدل عنه ولا محيص منه وهو غاية الجود الذي ليس وراءه غاية
أخرى لطالب مستزيدا وراغب مستفيد. والخائف منه هو الخائف من عدل الباري
وحكمته بل هو الخائف من وجوده وعطائه. فقد ظهر ظهورا حسيا أن الموت ليس
بردىء كما يظنه جمهو الناس وإنما الردىء هو الخوف منه وأن الذي يخاف هو
الجاهل به وبذاته. وقد ظهر أيضا فيما تقدم من قولنا أن حقيقة الموت هي
مفارقة النفس البدن وهذه المفارقة ليست فسادا للنفس وإنما هي فساد
المتركب. وأما جوهر النفس الذي هو ذات الإنسان ولبه وخلاصته فهو باق وليس
بجسم فيلزم فيه ما لزم في الأجسام مما أوردناه قبيل. بل لا يلزمه شيء من
أعراض الأجسام أي لا يتزاحف في المكان لإستغنائه عن المكان ولا يحرص على
البقاء الزماني لاستغنائه عن الزمان وإنما استفاد بالحواس والأجسام كمالا
فإذا كمل بها ثم خلص منها صار إلى عالمه الشريف القريب إلى بارئه ومنشئه
تعالى وتقدس.
وهذا الكمال الذي يستفيده في هذا العالم الحسي قد بيناه
وعرفناك الطريق إليه بما سلف من القول في هذا الباب وأنه السعادة القصوى
للإنسان وأعلمناك ضده الذي هو الشقاسء الأقصى له وبينا مع ذلك مراتب
السعادة ومنازل الأبرار ودرجاتهم من رضوان الله وجنته التي هي دار القرار
كما بينا لك أضدادها من سخطه ودركاتهم من النار التي هي الهاوية بلا قرار
نسأل الله حسن المعونة على ما يقربنا منه ويبعدنا من سخطه إنه جواد كريم
رؤوف رحيم.
علاج الحزن
الحزن ألم نفساني يعرض لفقد
محبوب أو فوت مطلوب. وسببه الحرص على القنيات الجسمانية والشره إلى
الشهوات البدنية والحسرة على ما يفقده أو يفوته منها. وإنما يحزن ويجزع
على فقد محبوباته وفوت مطلوباته من يظن أن ما يحصل له من محبوبات الدنيا
يجوز أن يبقى ويثبت عنده أو أن جميع ما يطلبه من مفقوداتها لا بد أن يحصل
له ويصير في ملكه فإذا انصف نفسه وعلم أن جميع ما في عالم الكون والفساد
غير ثابت ولا باق وإنما الثابت الباقي هو ما يكون في عالم العقل لم يطمع
في المحال ولم يطلبه وإذا لم يطمع فيه لم يحزن لفقده ما يهواه ولا لفوت ما
يتمناه في هذا العالم وصرف سعيه إلى المطلوبات الضافية واقتصر بهمته على
طلب المحبوبات الباقية وأعرض عما ليس في طبعه أن يثبت ويبقى وإذا حصل له
منه شيء بادر إلى وضعه في موضعه وأخذ منه مقدار الحاجة إلى دفع الآلام
التي أحصيناها من الجوع والعرى والضرورات التي تشبهها وترك الإدخار
والإستكثار والتماس المباهات والإفتخار ولم يحدث نفسه بالمكاثرة بها
والتمني لها. وإذا فارقته لم يأسف عليها ولم يبال بها. فإن من فعل ذلك أمن
فلم يجزع وفرح فلم يحزن وسعد فلم يشق. ومن لم يقبل هذه الوصية ولما يعالج
نفسه بهذا العلاج لم يزل في جزع دائم وحزن غير منتقص.
وذلك أنه لا يعدم
في كل حال فوت مطلوب أو فقد محبوب وهذا لازم لعالمنا هذا لأنه عالم الكون
والفساد. ومن طمع من الكائن الفاسد أن لا يكون ولا يفسد فقد طمع في المحال
لم يزل خائبا والخائب أبدا محزون والمحزون شقي. ومن استشعر بالعادة
الجميلة ورضى بكل ما يجده ولا يحزن لشيء يفقده لم يزل مسرورا سعيدا. فإن
ظن ظان أن هذا الإستشعار لا يتم له أو لا ينتفع به فلينظر إلى استشعارات
الناس في مطالبهم ومعايشهم وإختلافهم فيها بحسب قوة الإسشعار. فإنه سيرى
رؤية بينة ظاهرة فرح المتعيشين بمعايشهم على تفاوتها. وسرور أصحاب الحرف
المختلفة بمذاهبهم على تباينها. وليتصفح ذلك في طبقة طبقة من طبقات
الدهماء فإنه لا يخفى عليه فرح التاجر بتجارته والجندي بشجاعته والمقامر
بقماره والشاطر بشطارته والمخنث بتخنثه حتى يظن كل واحد منهم أن المغبون
من عدم تلك الحالة حتى فقد بهجتها والمجنون من غبي عنها فحرم لذتها. وليس
ذلك إلا لقوة إستشعار كل طائفة بحسن مذهبها ولزومها إياه بالعادة الطويلة.
وإذا لزم طالب الفضيلة مذهبه وقوى إستشعاره وحسن رأيه وطالت عادته كان
أولى بالسرور ومن هذه الطبقات الذين يخبطون في جهالاتهم وكان أحظاهم
بالنعيم المقيم لأنه محق وهم مبطلون. وهو متيقن وهم ظانون. ثم هو صحيح وهم
مرضى. وهو سعيد وهم أشقياء. وهو ولي الله عزوجل وهم أعداؤه وقد قال الله
عز منقائل (أَلاَ إنَّ أَولِياءَ الله لا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم
يَحزَنُونَ) وقال الكندي في كتاب دفع الأحزان. مما يدلك دلالة واضحة أن
الحزن شيء يجلبه الإنسان ويضعه وضعا وليس هو من الأشياء الطبيعية أن من
فقد ملكا أو طلب أمرا فلم يجده فلحقه حزن ثم نظر في حزنه ذلك نظرا حكيما
وعرف أن أسباب حزنه هي أسباب غير ضرورية وان كثيرا من الناس ليس لهم
ذلكالملك وهم غير محزونين بل فرحون مغبوطون علم علما لا ريب فيه أن الحزن
ليس بضروري ولا طبيعي.
وأن من حزن من الناس وجلب لنفسه هذا العارض فهو
لامحالة سيسلو ويعود إلى حاله الطبيعي. فقد شاهدنا قوما فقدوت من الأولاد
والأعزة والأصدقاء ما إشتد حزنهم عليه ثم لم يلبثوا أن يعودا إلى حالة
المسرة والضحك والغبطة ويصيرون إلى حال من لم يحزن قط.
ولذلك نشاهد من
يفقد المال والضياع وجميع ما يقتنيه الإنسان مما يعز عليه ويحزنه فإنه لا
محالة يتسلى ويزول حزنه ويعاود أنسه وإغتباطه. فالعاقل إذا نظر إلى أحوال
الناس في الحزن وأسبابه. علم أن ليس يختص من بينهم بمصيبة غريبة ولا يتميز
عنهم بمحنة بديعة وأن غايته من مصيبته السلوة. وأن الحزن هو مرض عارض يجري
مجرى سائر الرداآت فلم يضع لنفسه عارضا رديئا ولم يكتسب مرضا وضيعا أعني
مجتلبا غير طبيعي. وينبغي أن نتذكر ما قدمنا ذكره من حال من يحيا بتحية
على أن يشمها ويتمتع بهائم ثم يردها ليشمها غيره ويتمتع بها سواه فأطمعته
نفسه فيها وظن أنها موهوبة له هبة أبدية فلما أخذت منه حزن وأسف وغضب فإن
هذه حال من عدم عقله وطمع فيما لا مطمع فيه.
وهذه حالة الحسود لأنه يحب أن يسيد بالخيرات من غير مشاركة الناس.
والحسد
أقبح الأمراض وأشنع الشرور. لذلك قالت الحكماء من أحب أن ينال الشر أعدائه
فهو محب للشر ومحب الشر شرير. وشر من هذا من أحب الشر لمن ليس له بعدو.
وأسوأ من هذا حالا من أحب أن لا ينال أصدقاءه خير.
ومن أحب أن يحرم
صديقه الخير فقد أحب له الشر ويجب له من هذه الرداآت الحزن على ما يتناوله
الناس من الخيرات من قنياتنا وما ملكناه أو مما لم نقتنه ولم نملكه لأن
الجميع مشترك للناس وهي ودائع الله عند خلقه. وله أن يرتجع العارية متى
شاء على يد من شاء. ولا سيئة علينا ولا عار إذا رددنا الودائع وإنما العار
والسيئة أن نحزن إذا ارتجعت منا. وهو مع ذلك كفر للنعمة لأن أقل ما يجب من
الشكر للمنعم أن نرد عليه عاريته عن طيب نفس وتسرع إلى إجابته إذا إستردها
ولا سيما إذا ترك المعير علينا أفضل ما أعارنا وأرتجع أخسه.
قال وأعني
بالأفضل ما لا تصل إليه يد ولا يشركنا فيه أحد أعني النفس والعقل والفضائل
الموهوبة لنا هبه لا تسترد ولا ترتجع ويقول إن كان ارتجع الأقل الأخس كما
اقتضاه العدل فقد أبقى الأكثر الأفضل وأنه لو كان واجبا إن نحزن في
الأشياء الضارة المؤلمة وأن يقل القنية ما استطاع إذ كان فقدها سببا
للأحزان.
وقد حكى عن سقراط أنه سئل عن سبب نشاطه وقلة حزنه فقال: لأنني
لا أقتني ما إذا فقدته حزنت عليه. وإذ قد ذكرنا أجناس الأمراض الغالبة
التي تخص لنفسه الساعي لها فيما يخلصها من الآمها وينجيها من مهالكها أن
يتصفح الأمراض التي تحت هذه الأجناس من أنواعها وأشخاصها فيداوي بنفسه
منها ويعالجها بمقابلاتها من العلاجات الراغبة إلى الله عز وجل بعد ذلك في
التوفيق فإن التوفيق مقرون بالإجتهاد وليس يتم أحدهما إلا بالآخر.
هذا
آخر المقالة السادسة وهي تمام الكتاب والحمد لله رب العالمين والصلاة على
النبي محمد وآله وأصحابه أجمعين. وحسبنا الله ونعم المعين.