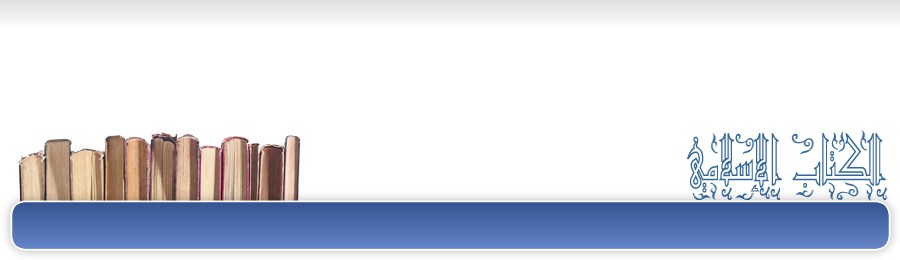كتاب : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين
المؤلف : الراغب الأصفهاني
بسم الله الرحمن الرحيم
في ذكر أجناس الموجودات وموضع الإنسان منها
إعلم أن الله تعالى هو الواجب الوجود الذي لا سبب لوجوده بل هو سبب كل موجود. وكلُّ موجود فمنه وبه تعالى وجوده. والموجودات ضربان: المعقولات العلوية والمحسوسات السفلية، وإيجاده تعالى للمعقولات العلوية قبل إيجاده للمحسوسات السفلية، كما رُوي أنه أول ما خلق الله تعالى القلم ثم اللوح، وقال: اجر بما هو كائن إلى يوم القيامة. وروي أنه أول ما خلق الله العقل فقال له: أقبل. فأقبل ثم قال له: أدبر. فأدبر فقال: بعزتي وجلالي ما خلقتُ خلقاً أكرمَ عليَّ منك بك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب وليس المراد بالعقل ههنا العقول البشرية بل الإشارة به إلى جوهر شريف عنه تنبعث العقول البشرية. وقال قوم: " العقل ههنا عبارة عن القلم المذكور في الخبر الآخر " والله أعلم.ثم أوجد الله تعالى الروحانيات الذين لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وإيجاد هذه الأشياء على سبيل الإبداع. والإبداع هو إيجاد الشيء لا عن شيءٍ موجود من قبل. ثم خلق الأركان الأربعة والجمادات والناميات والحيوانات، وختم بالصورة الإنسانية كما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " خلق الله تعالى يوم الأحد كذا ويوم الاثنين كذا إلى أن قال خلق الإنسان يوم الجمعة آخر نهار " . والخلق في أكثر الأحوال يقال في إيجاد الشيءِ من الشيءِ قبله كخلق الإنسان من التراب، ويقتضي تركيباً ولذلك قال اله تعالى: (ومن كل شيءٍ خَلَقنا زوجين لعلكم تذكَّرون). وإلى الأشياء المركَّبة أشار بقوله تعالى: (أو لم يروا إلى الأَرضِ كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم). واعلم أن كل شيءٍ من المبدعات فتامٌّ لا نقص فيه، ولو كان فيه نقص لدل ذلك على نقصان مبدعه وصانعه، فأَما المخلوق الذي هو مركب من شيء فقد يحتمل أن يكون فيه نقص ويكون نقصه عارضاً من جهة ما تركب منه لا من جهة مركِبه وفاعله، فلهذا صارت المبدعات من الأشياء العلوية معرّاة عن اعتراض الفساد فيها حالاً فحالاً، بل تبقى على حالتها إلى أن يشاء الله تعالى أن يرفع العالم.
والإنسان إنسانان: أحدهما آدم الذي هو أبو البشر، ويجري هو من سائر الناس مجرى البَذر الذي منه أنشئ غيره، والباري تعالى قد تولى بنفسه إيجاده وتربيته وتعليمه كما نبَّه عليه بقوله تعالى: (ما منعك أن تسجد لما خلقتُ بيديَّ). وقوله تعالى: (وَعلَّم آدم الأسماءَ كلَّها) والثاني بنوه وموجدهم أيضاً الباري تعالى، ولكن جعل انشاءَهم وتربيتهم وتعليمهم بوسائط جسمانية وروحانية، فالجسماني كالأبوين والروحاني كالملائكة المدّبرات والمقسّمات الذين يتولون انشاءَه وتربيته، كما روي في الخبر: الولد يكون أربعين يوماً نطفةً، ثم يصير علقة، ثم يصير مضغة، ثم يبعث الله ملكاً فينفخ فيه الروح، إلى غير ذلك من الأخبار. ولكون الأبوين سبباً في وجود الولد عظَّم الله تعالى حقهما وألزم بعد شكره شكرهما فقال: (اشكر لي ولوالديك). ويسمى الولد ابناً وهو مشتق من بنيتُ البنية تنبيهاً على أنه جار للأب مجرى البناءِ للباني.
الباب الثالث في ذكر العناصر التي منها أُوجد الإنسانفي ذكر العناصر التي منها أُوجد الإنسان
ذكر
الله تعالى العناصر التي خلق منها آدم عليه السلام، ونبَّه على أنه جعله
إنساناً في سبع درجات. وأشار إلى ذلك في مواضع مختلفة حسب ما اقتضته
الحكمة، فقال في موضعٍ خَلَقَه من تراب إشارةً إلى المبدأ الأول. وفي آخر
من طين إشارة إلى الجمع بين التراب والماء. وفي آخر من حمإٍ مسنون إشارة
إلى الطين المتغير بالهواء أدنى تغير. وفي آخر من طين لازب إشارة إلى
الطين المستقر على حالة من الاعتدال يصلح لقبول الصورة. وفي آخر من صلصال
من حمإٍ مسنون إشارة إلى يبسه وسماع صلصلة منه، وفي آخر من صلصال كالفخار،
وهو الذي قد أُصلح بأَثر من النار فصار كالزخرف، وبهذه القوة النارية حصل
في الإنسان أثر من الشيطنة وعلى هذا المعنى دلَّ بقوله: (خلق الإنسان من
صلصال كالفخَّار وخلق الجانَّ من مارج من نار). فنبه على أن الإنسان فيه
من القوة الشيطانية بقدر ما في الفخار من أثر النار وأن الشيطان ذاته من
المارج الذي لا استقرار له. ثم نبه الله على تكميل الإنسان بنفخ الروح فيه
فقال: (إني خالق بشراً من طين فإذا سوَّيتُه ونفخت فيه من روحي فقعوا له
ساجدين). فهذه سبع درجات نبه عليها كما ترى. ثم دلَّ على تكميل نفسه
بالعلوم والآداب بقوله تعالى: (وعلَّم آدم الأسماءَ كلَّها) ثم ذكر خلق
بني آدم وعناصرهم التي أوجدها حالةً بعد حالة، فنبه على أنه جعلهم أناساً
في سبع درجات حسب ما جعل آدم عليه السلام فقال تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان
من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا الإنسان من سلالة
من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة
مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأْناه خَلْقاً آخرَ
أشار به إلى ما جعل من له من قوة العقل والفكر والنطق. فإن قيل فلم قال
فكسونا العظام لحماً ولم يقل فخلقنا منه لحماً كما قال في الأول. قيل
إشارة منه تعالى إلى لطيفة من صنعه وهو أن النطفة انتهت إلى صورة العظم،
ثم أنشأ الله اللحم إنشاءاً آخر لا من النطفة، وأجراها مجرى الكسوة التي
قد يخلعها الإنسان ويجدّدُها، ولذلك إذا قطع من الحيوان لحمٌ عاد ولم يكن
كالعظم الذي لا يعود بعد قطعه فإن قيل كيف حكُم على جميع الناس أنه خلقهم
من سلالة من طين والمخلوق منها هو آدم دون أولاده. قيل أن ذلك على وجهين:
أحدهما أنه لما خلق آدم من دون أولاده. قيل أن ذلك على وجهين: أجدهما أنه
لما خلق آدم من سلالة من طين فأولاده الذين منه هو أيضاً منها. والثاني أن
الإنسان يتكوَّن من النطفة ويتربى بدم الطمث، وهما يتكوَّنان من الغذاءِ
والغذاءُ يتكوَّن من الحيوان، والحيوان من النبات، والنبات من سلالة من
طين، فإذاً الإنسان على الحقيقة من سلالة من طين، وعلى هذا نبَّه الله
تعالى بقوله: (إِنا صببنا الماءَ صبّاً ثم شققنا الأرض شقّاً فأنبتنا فيها
حباً وعنباً وقضباً). وقوله: (خلقكم من تراب ثم من نطفة). فجعله الله
تعالى من تراب على هذا الوجه. وقال: (ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا
أنتم بشرٌ تنتشرون).
وفي آخر: (خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من
سلالة من ماءٍ مهين). وعني بالإنسان ههنا آدم ولذلك قال: ثم جعل نسله.
فاقتصر ههنا على النطفة دون المبدأ الأول الذي هو التراب. وإنما ذكر هذه
المبادئ متفرقةً لحكمةٍ اقتضت تخصيص ذكر كل واحد من ذلك في موضعه مما يليق
بهذا الكتاب.
الباب الرابع
في ذكر قوى الأشياء التي جمعت في الإنسانالإنسان
قد جمع فيه قوى العالم، وأوجد بعد وجود الأشياء التي جمعت فيه، وعلى هذا
نبه الله تعالى بقوله: (الذي أحسن كل شيءٍ خَلْقَه وبدأَ خَلق الإنسان من
طين). وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم ذكره. وقد جمع الله تعالى
في الإنسان قوى بسائط العالم ومركباته وروحانياته وجسمانياته ومبدعاته
ومكوّناته. فالإنسان من حيث أنه بوساطة العالم حصل ومن أركانه وقواه أوجد
هو العالم. ومن حيث أنه صغُر شكله وجمع فيه قواه كالمختصر من العالم فإن
المختصر من الكتاب هو الذي قُلّل لفظه، وأستوفي معناه. والإنسان هكذا هو
إذا اعتبر بالعالم. ومن حيث أنه جعل من صفوة العالم ولبابه وخلاصته
وثمرته، فهو كالزُبْد من المخيض والدهن من السمسم، فما من شيءٍ إلا
والإنسان يشبهه من وجه، فإنه كالأركان من حيث ما فيه من الحرارة والبرودة
والرطوبة واليبوسة، وكالمعادن من حيث ما هو جسم، وكالنبات من حيث ما يتغذى
ويتربى، وكالبهيمة من حيث ما يحس ويتوهم ويتخيل ويلتذ ويتألم، وكالسبع من
حيث ما يحرض ويغضب، وكالشيطان من حيث ما يغوي ويضل، وكالملائكة من حيث ما
يعرف الله تعالى ويعبده ويخلفه، وكاللوح المحفوظ من حيث قد جعله الله مجمع
الحكم التي كتبها فيه على الاختصار - فقد ذكر بعض الحكماء في بدن الإنسان
أربعة آلاف حكمة، وفي نفسه قريباً من ذلك. وكالقلم من حيث ما يثبت بكلامه
صور الأشياء في قلوب الناس كما أن القلم يثبت الحكم في اللوح المحفوظ.
ولكون الإنسان من قوى مختلفة قال الله تعالى: (اناّ خلقنا الإنسان من نطفة
أمشاج) أي مختلطة من قوى أشياء مختلفة. ولكون العالم والإنسان متشابهين
إذا اعتبر قيل الإنسان عالم صغير والعالم إنسان كبير ولذلك قال الله
تعالى: (ما خَلْقكم ولا بعثكم الاّ كنفس واحدة). فأشار بالنفس الواحدة إلى
ذات العالم. ولما كان كل مركب من أشياء مختلفة يحصل باجتماعهنَّ معنى ليس
بموجود فيهن على انفرادهن كالمركبّات من الأدوية والأطعمة، كذلك في نفس
الإنسان حصل معنى ليس فس شيءٍ من موجودات العالم، وذلك المعنى هو ما يختص
به من خصائصه التي بها تميَّز عن غيره من هيئات له، كانتصاب القامة وعرض
الظُّفر، وانفعالات له كالضحك والحياء، وأفعال كتصور المعقولات وتعلم
الصناعات واكتساب الأخلاق.
الباب الخامس
في تكوين الإنسان شيئاً فشيئاً حتى يصير إنساناً كاملاً الإنسان يكون أولاً جماداً ميتاً قال الله تعالى: (وكنتم أمواتاً فأحياكم) وذلك حيث كان تراباً وطيناً وصلصالاً ونحوها. ثم يصير نباتاً نامياً كما قال الله تعالى: (والله أنبتكم من الأرض نباتاً) وذلك حيث ما كان نطفة وعلقة ومضغة ونحوها. ثم يصير حيواناً وذلك حيث ما يتبع بطبعه بعض ما ينفعه ويحترز من بعض ما يضره. ثم يصير إنساناً مختصاً بالأفعال الإنسانية وقد نبه الله تعالى على ذلك في مواضع نحو قوله: (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلَّقة وغير مخلَّقة). وقوله: (أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوَّاك رجلاً). فأول ما يظهر فيه قوة النزاع الموجودة في النبات والحيوان، ثم قوة تناول الموافق ودفع المخالف، ثم الحس ثم التخيل ثم التصور ثم التفكر ثم العقل، فهو لم يصر إنساناً إلاّ بالفكر والعقل الذي يميز بين الخير والشر والجميل والقبيح. وإلى العقل أشار الله تعالى بقوله: (وصوَّركم فأحسن صوَرَكم). فالإنسان بعقله صار معدن العلم ومركز الحكمة. ووجود العقل فيه إبتداء الأمر بالقوة كوجود النار في الحجر المحتاج في أن يري إلى الاقتداح، وكوجود النخل في النوى المحتاجة في أن تثمر إلى غرس وسقي. وكوجود الماء تحت الأرض المحتاجة في الاستقاءِ منه إلى حفره ونفس الإنسان واقعة بين قوتين: قوة الشهوة وقوة العقل، فبقوة الشهوة يحرص على تناول اللذات البدنية البهيمية كالغذاء والسفاد والتغالب وسائر اللذات العاجلة، وبقوة العقل يحرص على تناول العلوم والأفعال الجميلة والأمور المحمودة العاقبة، وإلى هاتين القوتين أشار الله تعالى بقوله: (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا). وبقوله: (وهديناه النَّجْدَين).ولما كان من جبلة الإنسان
أن يتحرى ما فيه اللذة، وكانت اللذات على ضربين: أحدهما محسوس كلذة
المذوقات والملموسات والمشمومات والمسموعات والمبصرات وهي من توابع الشهوة
الحيوانية، والثاني معقول كلذة العلم وتعاطي الخير وفعل الجميل. واللذات
المحسوسة أغلب علينا لكونها أقدم وجوداً فينا، لأنها توجد في الإنسان قبل
أن يولد، وهي ضرورية في الوقت ولذلك قال الله تعالى: (يحبون العاجلة
ويذرون الآخرة) ولذلك يكره أكثر الناس ما يأمر به العقل ويميل إلى ما يأمر
به الهوى حتى قيل: " العقل صديق مقطوع والهوى عدوّ متبوع " . ولذلك قال
النبي صلى الله عليه وسلم " حُفَّت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات "
ولذلك يحتاج الإنسان أن يقاد في بدءِ أمره إلى مصالحه بضرب من القهر حتى
قال صلى الله عليه وسلم: " يا عجباً لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل " .
فحقُّ الإنسان أن يجاهد هواه إلى أن يقتحم العقبة فيتخلص حينئذٍ من أذاه.
وللنفس
نظران: نظرٌ إلى فوق نحو العقل، ومنه تستمد المعارف، وتميز بين المحاسن
والقبائح، فتعرف كيف تتحرى المحاسن وتتجنب القبائح. ونظرٌ إلى تحت نحو
الهوى، وبه تنسى الحقائق وتألف الخسيسات بل القاذورات. والنفس متى كانت
شريفة أَدامت النظر إلى فوق كما ذكرنا، ولا تنظر إلى ما دونها إلا عند
الضرورة، ولا تتناول اللذات البدنية إلا بحسب ما يرسمه العقل المستمد من
الشرع، أو إذا كانت دنيَّة أكثرت الميل إلى الشهوات البدنية، فيحدث ذلك
لها إذعاناً وانقياداً لللشهوات فيستعبدها الهوى كما قال الله تعالى:
(أَفرأَيْتَ مَن اتخذ إلهه هواه وأَضلَّه الله على علْم) وإنما أضله بعد
أن اتخذ إلهه هواه وجعله عبداً لأغراض دنيوية كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم: " تعس عبد الدرهم " . الخبر. ومن هذه العبودية استعاذ إبراهيم
الخليل عليه السلام حيث قال: (واجْنُبني وبَنيَّ أَن نعبد الأصنام).
الباب السادس
في ظهور الإنسان في شعار الموجودات وتخصيصه بقوة شيء فشيء منها ذات الإنسان من حيث ما اجتمع فيه قوى الموجودات صار وعاء معاني العالم وطينة صوره ومعدن آثاره ومجمع حقائقه، وكأنه مركب من جمادات ونباتات وبهائم وسباع وشياطين وملائكة، ولذلك قد يظهر في شعار كل واحد من ذلك فيجري تارة مجرى الجمادات في الكسل وقلة التحرك والإنبعاث، وعلى هذا نبه الله تعالى بقوله: (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدُّ قسوة) وقد يظهر في شعار النباتات الحميدة أو الذميمة فيصير إِما كالأُترج الذي يطيب حمله ونَوْره وعوده وورقه أو كالنخل والكرم فيما يؤتي من النفع، أو كالكشوث في عدم الخير، أو كالحنظل في خبث المذاق، وعلى هذا نبه الله تعالى بقوله: (مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كلَّ حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجْتُثَّت من فوق الأرض ما لها من قرار). ويظهر تارة في شعار الحيوانات المحمودة والمذمومة، فيصير أما كالنحل في كثرة منافعه وقلة مضاره وفي حسن سياسته. قال الله تعالى: (وأَوحى ربك إلى النحل أَن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون) أو كالطير المسمى بأبي الوفا، أو كالخنزير في الشره، أو كالذئب في العيث، أو كالكلب في الحرص، أو كالنمل في الجمع، أو كالفأر في السرقة، أو كالثعلب في المراوغة، أو كالقرد في المحاكاة، أو كالحمار في البلادة، أو كالثور في الفظاظة، وعلى هذا النحو من المشابهات دلَّ الله بقوله: (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلاّ أُمم أمثالكم ما فرَّطنا في الكتاب من شيءٍ ثم إلى ربهم يحشرون) ويظهر تارة في شعار الشياطين فيغوي ويضل ويسول بالباطل في صورة الحق كما دل الله تعالى بقوله: (شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) وإنما يكون إنساناً إذا وضع كل واحد من هذه الأشياء في موضعه حسب ما يقتضيه العقل المرتضي المستبصر بنور الشرع.الباب السابعفي ماهية الإنسان
ماهية
كل شيءٍ تحصل بصورته التي يتميز بها عن أغياره، كصورة السكين والسيف
والمنجل ونحوها. ولما كان الإنسان جزئين بدن محسوس وروح معقول كما نبه
الله تعالى عليه بقوله: (إني خالق بشراً من طين فإذا سوَّيته ونفختُ فيه
من روحي فقعوا له ساجدين) كان له بحسب كل واحد من الجزئين صورة، فصورته
المحسوسة البدنية انتصاب القامة وعرض الظفر وتعري البشرة عن الشعر والضحك.
وصورته المعقولة الروحانية العقل والفكر والرويّة والنطق. قالوا فالإنسان
هو الحيوان الناطق، ولم يعنوا بالناطق اللفظ المعبر به فقط، بل عنوا به
المعاني المختصة بالإنسان فعبروا عن كل ذلك بالنطق فقد يعبر عن جملة الشيء
بأخص ما فيه أو بأشرفه أو بأوله، كقولك سورة الرحمن وسورة يوسف وسورة
لإيلاف ونحو ذلك، فالإنسان يقال على ضربين عام وخاص فالعام أن يقال لكل
منتصب القامة مختص بقوة الفكر واستفادة العلم، والخاص أن يقال لمن عرف
الحق فاعتقده والخير فعمله بحسب وسعه، وهذا معنى يتفاضل فيه الناس
ويتفاوتون فيه تفاوتاً بعيداً، وبحسب تحصيله يستحق الإنسانية وهي تعاطي
الفعل المختص بالإنسان فيقال فلان أكثر إنسانية. وكما يقال الإنسان على
وجهين يقال له الحيوان الناطق على وجهين عام ويراد به مَنْ في قوة نوعه
استفادة الحق والخير، كقولك الإنسان هو الكاتب دون الفرس والحمار، أي هو
الذي في قوته استفادة الكتابة. وكذا يقال له عبد الله على وجهين: عام
ويراد به الحيوان المتعرض لارتسام أوامر الله ارتسم أو لم يرتسم وهو
المشار إليه بقوله تعالى: (إِن كل من في السموات والأرض الاّ آتي الرحمن
عبداً) وخاصٌّ وهو المرتسم لأوامر الله تعالى كما قال سبحانه: (إن عبادي
ليس لك عليهم سلطان) وكذا يقال له حيٌّ وسميع وبصير ومتكلم وعاقل كل ذلك
على وجهين: يقال عاماً وهو لمن له الحياة الحيوانية التي بها الحس والتخيل
والنزوع والشهوة ولمن سمع الأصوات ولمن يدرك الألوان، ولمن يُفهم الكافة
بما يريده، ولمن له القوة التي يتبعها التكليف، والثاني يقال له خاصاً وهو
لمن له الحياة التي هي العلم المقصود بقول الله تعالى: (لِيُنْذِر مَن كان
حياً) وله السمع الذي به يسمع حقائق المعقولات، والبصيرة التي بها يدرك
الاعتبارات، واللسان الذي به يورد التحقيقات، وهي التي نفاها عن الجهلة
الكفرة في قوله تعالى: (صمٌّ بكمٌّ عميٌ فهم لا يعقلون).
الباب الثامن
في كون الإنسان مستصلحاً للدارين الإنسان من بين الموجودات مخلوق خلقة تصلح للدارين، وذلك أن الله تعالى قد أوجد ثلاثة أنواع من الأحياء، نوعاً لدار الدنيا وهي الحيوانات، ونعاً للدار الآخرة وهو الملأ الأعلى، ونوعاً للدارين وهو الإنسان، فالإنسان واسطة بين جوهرين وضيع وهو الحيوانات، ورفيع وهو الملائكة، فجمع فيه قوى العالمين وجعله كالحيوانات في الشهوة البدنية والغذاء والتناسل والمهارشة والمنازعة وغير ذلك من أوصاف الحيوانات. وكالملائكة في العقل والعلم وعبادة الرب والصدق والوفاءِ، ونحو ذلك من الأخلاق الشريفة ووجه الحكمة في ذلك أنه تعالى لما رشحه لعبادته وخلافته وعمارة أرضه وهيأه مع ذلك لمجاورته في جنته اقتضت الحكمة أن يجمع له القوتين، فإنه لو خُلق كالبهيمة معرىّ عن العقل لما صلح لعبادة الله تعالى وخلافته، كما لم يصلح لذلك البهائم ولا لمجاورته ودخول جنته. ولو خلق كالملائكة معرىّ عن الحاجة البدنية لم يصلح لعمارة أرضه كما لم يصلح لذلك الملائكة حيث قال تعالى في جوابهم: (إِني أعلمُ ما لا تعلمون) فاقتضت الحكمة الإلهية أن تجمع له القوتان، وفي اعتبار هذه الجملة تنبيه على أن الإنسان دنيويٌّ وآخرويٌّ، وأنه لم يُخلق عبثاً كما نبه الله عليه بقوله: (أَفحسبتم أَنما خلقناكم عبثاً وأَنكم إلينا لا ترجعون).الباب التاسعفي تمثيل ذات الإنسان وتصويره
قد
ذكر الحكماء لذات الإنسان وقواها مثالاً صوَّرها بها، فيتمثل كل ما لا
يدرك إلا بالعقل بتصور الحس ليقرب من الفهم، فقالوا: ذات الإنسان لما كان
عالماً صغيراً كما تقدم جرى مجرى بلد أحكم بناؤه، وشيد بنيانه، وحُصّن
سوره، وخُطَّت شوارعه، وقسمت محاله وعُمرت بالسكان دوره، وسلكت سبله،
،اجريت أنهاره، وفتحت أسواقه، واستعملت صناعه، وجعل فيه ملك مدبر، وللملك
وزير وصاحب بريد وأصحاب أخبار وخازن وترجمان وكاتب وفي البلد أخيار
وأشرار. فصناعها هي القوى السبعة التي يقال لها الجاذبة والماسكة والهاضمة
والدافعة والنامية والغاذية والمصورة والملك العقل ومنبعه من القلب.
والوزير القوة المفكرة ومسكنها وسط الدماغ. وصاحب البريد القوة المتخيلة
ومسكنها مقدم الدماغ. وأصحاب الأخبار الحواس الخمس ومسكنها الأعضاء
الخمسة. والخازن القوة الحافظة ومسكنها الدماغ. والترجمان القوة الناطقة
وآلتها اللسان. والكاتب القوة الكاتبة وآلتها اليد، وسكانها الأخيار
والأشرار هي القوى التي منها الأخلاق الجميلة والأخلاق القبيحة، وكما أن
الوالي إذا تزكى وساس الناس بسياسة الله صار ظل الله في الأرض كما روي أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " السلطان ظل الله في الأرض ويجب على
الكافة طاعته " كما قال الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
الأمر منكم) كذلك متى جُعل العقل سائساً وجب على سائر قوى النفس أن تطيعه.
وكما أن الله تعالى جعل الناس متفاوتين كما نبه الله تعالى عليه بقوله:
(ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريّاً). كذلك جعل قوى
النفس متفاوتة وجعل من حق كل واحدة أن تكون داخلة في سلطان ما فوقها
ومتأمرة على ما دونها. فحق القوة الشهوانية أن تكون مؤتمرة للقوة العاقلة،
وحق القوة العاقلة أن تكون مستضيئة بنور الشرع ومؤتمرة لمراسمه، حتى تصير
هذه القوى متظاهرة غير متعادية كما قال الله تعالى: (ونزعنا ما في صدورهم
من غِلّ إخواناً على سُرُرٍ متقابلين). وكما لا ينفك أشرار العالم من أن
يطلبوا في العالم الفساد ويعادوا الأخيار كما قال تعالى: (وكذلك جعلنا لكل
نبي عدوّاً شياطين الأنس والجن). كذلك في نفس الإنسان قوى رديئة من الهوى
والشهوة والحسد تطلب الفساد وتعادي العقل والفكر. وكما نبه أنه يجب للوالي
أن يتبع الحق ولا يُصغي إلى الأشرار ولا يعتمدهم كما قال تعالى: (يا أيها
الذين آمنوا لا تتخذوا بطانةً من دونكم..). وقال تعالى: (يا أيها الذين
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء). وقال: (وأَن احكم بينهم بما
أَنزل الله ولا تَتَّبعْ أهواءهم واحذَرْهم أَن يفتنوك). كذلك يجب للعقل
والفكر أن لا يعتمد القوى الذميمة.
وكما أنه يجب للوالي أن يجاهد اعداء
المسلمين كما قال تعالى: (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
ترهبون به عدوَّ الله وعدوكم). وكذلك يجب للعقل أن يعادي الهوى فإن الهوى
من اعداء الله بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما في الأرض معبود
ابغض الى الله من الهوى " ثم تلا (أفرأيت من أتخذ آلهة هواه) وكما أن من
استحوذ عليه الشيطان انساه ذكر الله، وكذلك العقل إذا استحوذ عليه الهوى.
كما أنه يجب للوالي أن يسالم اعاديه إذا لم يقو عليهم كما قال الله
تعالى:(وان جنحوا للسلم فاجنح لها) وان لا يركن اليهم وان سالمهم كما قال
الله تعالى: (ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) كذلك يجب للعقل ان
يسالم الاشرار من قوى النفس اذا عجز عنها وان لا يركن اليها.
وكما
ان الوالي اذا احس بقوة احتاج الى ان يعدل الى نقض العهد واظهار المعاداة
كما قال الله تعالى: (فإذا انسلخ الاشهر الحرُمُ فاقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم وخُذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كلَّ مرصد). كذلك حق العقل اذا قوي
على قوى النفس ان لا يداهنها. وكما ان شياطين الانس والجن يضعف كيدهم على
من تحصن بالايمان واستعاذ بالله وتقوَّى على من والاه كما قال تعالى:
(إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) كذلك يضعفُ كيد
الهوى عن العقل إذا تقوَّى بالله واستعاذ به. فحقُّ العقل أن يستعيذ من
الهوى والشره والحرص والأمل وأن يطهر ذاته منها ومن سائر القوى الرديئة،
استعاذة إبراهيم صلوات الله عليه حيث قال: (رب اجعل هذا البلد آمناً
واجنبني وبَنيَّ أن نعبد الأصنام). فالقوى الرديئة والإرادات الرديئة في
ذات الإنسان جارية مجرى أصنام قلَّ ما ينفك الإنسان من عبادتها كما قال
الله تعالى: (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) وذكروا مثلاً آخر
فقالوا: " كل إنسان مع بدنه كوالٍ في بلد قيل له طهّر بلدك من النجاسات
وادّب من يقبل التأديب من أهله ورُضْ من يقبل الرياضة من حيوانه وسباعه.
ومن عاث فيه ولا يقبل التأديب والرياضة فاحبسه أو اقتله ولكن بالحق " كما
قال الله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرّمَ اللهُ إلاّ بالحق). فإن
عجزت عن تطهير عرصته من الأنجاس، وعن تأديب طغاته ورياضة حيواناته وسباعه،
فلا تعجز عن صيانة نفسك عن التلطخ بنجاساته، وعن الاحتراس من أن تفترسك
سباعه، وأن يسبيك طغاته حتى إذا لم تكن غالباً لم تكن مغلوباً. فصار الناس
في ذلك بين ثلاثة أصناف: صنف لم يفعل ما أُمر، ولم يؤَد حق الإيالة،
وتهاون فيما فوض إليه، فجرح وأُسر فصار عند نفسه مع كونه مجروحاً مأسوراً
ملوماً مخذولاً. وصنف فعل ما أُمر فأَدى حق الإيالة، فصار عند ربه مأجوراً
مشكوراً. وصنف جدَّ تارة وقصَّر تارة، فجرح وجُرح، وغَلب وغُلب. فهو كما
قال تعالى: (خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم) وقال
بعضهم: :الإنسان إذا اعتُبر مع قوة التخيل وقوة الغضب وقوة الشهوة فمثله
مثل من بلي في سفره بصحبة ثلاثة اضطر إليهم حتى لا يمكنه أن ينفصل منهم
ويقضي سفره من دونهم " كما قال الشاعر:
ومن نكد الدنيا على الحرّ أن يرى ... عدوًّا له ما من صداقته بدُّ
فيا نكد الدنيا متى أنت نازح ... عن الحر حتى لا يقاربه ضد
فواحدٌ
أمامههو له رقيب يحفظه، وعين تكلأه، لكنه مَلق باهت مموّه يلفق الباطل
تلفيقاً، ويختلق الزور اختلاقاً، فيخلط الكذب بالصدق والخطأ بالصواب.
والثاني عن يمينه بطش زَعر، يحميه عن أعاديه، لكنه كثيراً ما يغويه، فيهيج
هائجه فلا يقمعه النصحُ ولا يطأطئه الرفق، كأنه نار في حطب أو سيل في صبب
أو قَرْمٌ مُغْتَلِم، أو سبعٌ ثاكل، فيحتاج أن يسكنه دائماً فيحتمي به
ومنه فهو معه كما قيل: " راكب الأسد يهابه الناس وهو في نفسه أهيب "
والثالث عن يساره وهو الذي يأتيه بالمطعم والمشرب ولكنه أرعن ملق قَذِر
شَبِق كإنه خنزير أجيع فأٌرسل في جِلَّة يأتيه أحياناً بأطعمة خبيثة
فيكرهه على تناولها، فهو يحتاج أن يصابرهم حتى يقطع سفره، فيبلغ أرضاً
مقدسة يشرق فيها النور ويشرب فيها الذئب والنعجة من حوض واحد فيأمن فيها
بوائقهم، ومن حيلته التي ترجى أن يسلم منهم بها أن يسلط هذا البطش الزّعِر
على هذا الأرعن الملق حتى يزبره زبراً وأن يطفي غلو هذا الزعر التائه
بخلابة هذا الأرعن المَلِق، وأن لا يجنح إلى الباهت المتخرص حتى يؤتيه
موثقاً من الله غليظاً ثم يصدقه فيما ينهيه إليه، فجعل الملق الباهت كناية
عن الوهم، والبطش الزعر عن الغضب، والأرعن الملق عن الشهوة، وجعل الأرض
المقدسة عبارة عن دار السلم، وذكر أن حيلته في أن يسلم منهم أن يدفع بعض
هذه القوى ببعض دفع الشر بالشر.
الباب العاشر
في كون الإنسان هو المقصود من العالم وإيجاد ما عداه لأجلهالمقصود
من العالم وإيجاده شيئاً بعد شيء هو أن يوجد الإنسان، فالغرض من الأركان
أن يحصل منها النبات، ومن النبات أن تحصل الحيوانات، ومن الحيوانات أن
تحصل الأجسام البشرية ومن الأجسام البشرية، أن يحصل منها الأرواح الناطقة،
ومن الأرواح الناطقة أن يحصل منها خلافة الله تعالى في أرضه فيتوصل
بلإيفاء حقها إلى النعيم الأبدي كما دلَّ الله تعالى عليه بقوله: (إني
جاعل في الأرض خليفة). وجعل تعالى الإنسان سلالة العالم وزبدته وهو
المخصوص بالكرامة كما قال تعالى: (ولقد كرَّمنا بني آدم وحملناهم في البر
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً). وجعل
ما سواه كالمعونة له كما قال تعالى في معرض الامتنان: (هو الذي خلق لكم ما
في الأرض جميعاً). فليس فضله بقوة الجسم، فالفيل والبعير أقوى جسماً منه،
ولا بطول العمر فالنسر والحية أطول منه عمراً، ولا بشدة البطش فالأسد
والنمر أشد منه بطشاً، ولا بحسن اللباس والدراج أحسن منه لباساً، ولا
بالقوة على النكاح فالحمار والعصفور أقوى منه نكاحاً، ولا بكثرة الذهب
والفضة فالمعادن والجبال أكثر منه ذهباً وفضةً. وما أحسن قول الشاعر:
لولا العقول لكان أدنى ضيغم ... أدنى إلى شرف من الإنسان
ولما تفاضلت النفوس ودبرت ... أيدي الكماة عواليَ المرَّان
ولا
بعنصره الموجود منه كما زعم ابليس حيث قال: (خلقتني من نار وخلقته من
طين). بل ذلك بما خصه الله تعالى به، وهو المعنى الذي ضمنه فيه، والأمر
الذي رشحه له، وقد أشار إليه تعالى بقوله: (فإذا سويتُه ونفختُ فيه من
روحي فقعوا له ساجدين) وبقوله: (خلقتُ بيديَّ). والملائكة لما نبههم الله
تعالى لفضل آدم تنبهوا فأذعنوا وسجدوا له كما أُمروا. وإبليس لما نظر إلى
ظاهر آدم وبدئه وتعامى عما ذكر الله تعالى، ولم يتأمل المعنى الذي ضمنه
الله تعالى آدم، والعاقبة التي جعلها له أبى واستكبر. وقد اقتدى به الكفار
في ردّ الأنبياء حيث قالوا: (ما هذا إلاّ بشرٌ مثلكم يريد أن يتفضل
عليكم). وقالوا: (ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق). وقد نبه
الله تعالى على أن الاعتبار بفضلهم ليس بظاهر أبدانهم وإنما ذلك لمعاني في
نفوسهم يعمى عنها الكفار فقال عزَّ من قائل: (وتراهم ينظرون إليك وهم لا
يبصرون). أي لا يعرفون ما فضلتهم به. فمن وفّق لفضل ما أٌعطي ولما رُشح له
وأُعدَّ ثم سعى في مثاله، فقد أُوتي خيراً كثيراً وما يذَّكر الاّ أُولو
الألباب.
الباب الحادي عشر
في الغرض الذي لأجله أوجد الإنسان ومنازلهم الغرض منه أن يعبد الله ويخلفه وينصره ويعمر أرضه كما نبه الله تعالى بآيات في مواضع مختلفة حسب ما اقتضت الحكمة ذكره وذلك قوله تعالى: (وما خلقتُ الجنَّ والإنس إلا ليعبدون) وقوله: (إني جاعل في الأرض خليفة) وقوله: (ليستخلفنهم في الأرض) وقوله: (ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب) وقوله: (يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله) وقوله: واستعمركم فيها. وكل ذلك إشارة إلى توليتهم أموراً لم يستصلح لها الإنسان، كما نبه الله تعالى عليه بقوله للملائكة: (إني أعلم ما لا تعلمون). وذلك أن الله تعالى ما كان موجداً لما هو موجده وفاعلاً لما هو فاعله إلا على أربعة أوجه: الأول أفعال تولاَّها بذاته، وهي الإبداع ومعنى الإبداع هو إيجاد الشيء من العدم وإليه الإشارة بقوله تعالى: (بديع السموات والأرض).والثاني
أفعالٌ استعبد فيها ملائكته وسماه قوم التكوينات، وذلك إخراج الشيء من
النقص إلأى الكمال إخراجاً غير محسوس فاعله، وبذلك وصفهم الله تعالى
بقوله: (فالمدبرات أمراً) وهم ثلاثة أضرب: ضرب إليهم القيام بالأجرام
السماوية، وقد قيل هم إسرافيل وميكائيل ورضوان والمحتفُّون بالعرش
الموصوفون بقوله تعالى: (وترى الملائكة حافّين من حول العرش يسبحون بحمد
ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين) وقوله تعالى: (الذين
يحملون العرش ومن حوله.. الآية). وضرب إليهم تدبير الأركان الهوائية
كالملائكة الباعثة للرياح والمزجية للسحاب الموصوفين بقوله تعالى:
(والمرسلات عُرْفاً) وقوله عز وجل: (والنازعات غرقاً) وضرب إليهم تدبير
الأرض كالموصوفين بقوله تعالى: (له معقّبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه
من أمر الله). وكمن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الجنين أنه يبعث
ملكاً فينفخ فيه الروح وكالحفيظ والرقيب والعتيد وكمن وصفهم الله بقوله:
(ألن يكفيكم أن يمدَّكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين).
والثالث
أفعالٌ سخر الله تعالى لها الأركان وموجودات العالم كالإحراق والإذابة
للنار والترطيب للماء، وفي الجملة ما قد سخر تعالى له شيئاً فشيئاً من
لجمادات والناميات وغير ذلك، ونبه عليه بقوله تعالى: (وسخر لكم الشمس
والقمر). وغير ذلك من الآيات المذكورة.
والرابع الصناعات والمهن
المحسوسة التي استعبد الإنسان فيها واستخلفه، وهي الأشياءُ التي يحتاج
صناعة أكثرها إلى ستة أشياء، إلى عنصر تعمل منه، وإلى مكان وإلى زمان وإلى
حركة وإلى أعضاء وإلى آلة، وهذا الضرب خص الإنسان به ولم يستصلح له
الملائكة، وجعل لكم من الملَك مقاماً معلوماً كما نبه عليه تعالى بقوله:
(وما منا إلاّ له مقام معلوم). وكذلك جعل لكل نوع من الناس مقاماً معلوماً
كما نبه عليه بقوله: (قل كلٌّ يعمل على شاكلته) وقوله: (انظر كيف فضَّلنا
بعضهم على بعض). وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " كلٌّ مُيَسَّرٌّ لما
خُلق له " . ولكن عامة الملائكة لم يعصوا الله فيما أمرهم كما وصفهم تعالى
بقوله: (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) والناس فيما أُمروا به
وكلفوه بين مطيع وعاصٍ فهم على القول المجمل ثلاثة أضرب: ضرب اخلُّوا
بأمره، وانسلخوا عما خُلقوا لأجله، واتبعوا خطوات الشيطان وعبدوا الطاغوت.
وضرب وقفوا بغاية جهدهم حيث ما وقفوا كالموصوفين بقوله تعالى: (وعباد
الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً) وضرب ترددوا بين الطريقين كما قال
الله تعالى: (خلطوا عملاً صالحاً وأ آخر سيئاً) فمن رجح حسناته على سيئاته
فموعود بالإحسان إليه. وعلى الأنواع الثلاثة دل الله تعالى بقوله: (وكنتم
أزواجاً ثلاثة فأصحابُ الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ما أصحاب
المشئمة والسابقون السابقون أولئك المقرَّبون) وعلى هذا أقسم الله تعالى
في آخر السورة فقال: (فأما إن كان من المقرَّبين فرَوْحٌ وريحانٌ وجنة
نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلامٌ لك من أصحاب اليمين وأما إن كان
من المكذّبِين الضالين فنزُلٌ من حميم وتصلية جحيم). وكثيرٌ من الناس
يعصون الله، ولا يأتمرون له. فقيضهم الله تعالى بغير إرادة منهم للسعي في
نصرته من حيث لا يشعرون كفرعون في أخذ موسى وتربيته. وكجمعه السحرة ليكون
سبباً في إيمانهم. وأخوة يوسف في فعلهم ما أفضى به إلى ملك مصر وتمكنه مما
تمكن منه، ويكون مثلهم في ذلك كما قيل:
قصدت مساتي فاجتلبتَ مسرَّتي ... وقد يُحسِنُ الإنسان من حيث لا يدري
وقال آخر:
فعل الجميلَ ولم يكن من قصده ... فقبلته وقرنته بذنوبه
ولرب َّ فعل جاءَني من فاعل ... فحمدته وذممتُ من يأتي به
فيكون فعلُه محموداً وفاعله مذموماً كما قيل:
رُبَّ امرٍ أتاك لا تحمد ال ... فُعَّال وتحمد الأفعالا
وقد
أوجد الله تعالى كل ما ما في العالم للإنسان كما نبه عليه بقوله تعالى:
(جعل لكم الأرض فراشاً والسماءَ بناءً وأنزل من السماءِ ماءً فأخرج به من
الثمرات رزقاً لكم). وقال تعالى: (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض...
الآية). وقال عزَّ وجل: (وسخر لكم ما في الأرض). وقوله تعالى: (هو الذي
أنزل من السماءِ ماءً لكم منه شراب ومنه شجر فيه تُسيمون ينبت لكم به
الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار.. الآية). وأباح جميعها لهم كما نبه الله
تعالى عليه بقوله: (قلْ مَنْ حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات
من الرزق). فللإنسان أن ينتفع بكل ما في العالم على وجهه، أما في غذائه أو
في دوائه أو في ملابسه ومشموماته ومركوباته، وزينته والالتذاذ بصورته، أو
رؤيته والاعتبار به، وبإستفادة علم منه والافتداءِ بفعله فيما يستحسن منه،
والاجتناب عنه فيما يستقبح منه، فقد نبه الله تعالى على منافع جميع
الموجودات، واطلع الخلائق عليها أما بألسنة الأنبياء عليهم السلام، أو
بإلهام الأولياء رضي الله عنهم، وكما أنَّ حق الإنسان أن يعرف منافع
الحيوانات في ذواتها فينتفع بها في المطاعم والملابس والأدوية، فحقه أن
يعرف أخلاقها وأفعالها فينتفع بها في اجتناء ما يستحسن واجتناب ما يستقبح
منها. فقد أحسن من قال: " تعلمتُ من كل شيءٍ أحسن ما فيه حتى من الكلب
حمايته على أهله. ومن الغراب بكورة في حاجته " وقد أشار الله تعالى إلى
ذلك في وصف النحل فقال: (وأَوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً
ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات.. الآية) فنبه على أن الإنسان
حقه أن يقتدي بالنحل في مراعاته لوحي الله عزَّ وجل، فكما أنها لا تتخطى
وحي الله في تحري المصالح طبعاً، كذلك يجب على الإنسان أن لا يتخطى وحي
الله اختياراً.
الباب الثاني عشر
في تفاوت الناس واختلافهم الأشياءُ كلها متساوية غير متفاوتة من حيث أنها مصنوعة بالحكمة، وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله: (ما ترى في خَلْق الرحمن من تفاوت). ومختلفة من حيث أن كل نوع يختص بفائدة، وكل نوع وأن اختلف فما من شيء أكثر اختلافاً من الناس، كما قال الله تعالى: (وقد خلقكم أطواراً) وقال تعالى: (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) وقال سبحانه وتعالى: (أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً) وقال سبحانه: (ولو شاءَ الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم) وقال تعالى: (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم) وقال سبحانه: (ولو شاءَ ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلاّ من رحم ربك) وعلى هذا نبه الله تعالى بقوله: (وفي الأرض قطَعٌ متجاوراتٌ وجنات من أعناب وزرع (إلى قوله) إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون). والحكمة المقتضية لذلك هو أن الإنسان لما كان غير مكفي بتفرده بقاؤه أدنى مدة، فإن أول ما يحتاج الإنسان إليه ما يواريه وما يغذوه، وليس يجد ما يواريه مصنوعاً، ولا ما يغذوه مطبوخاً، كما يكون لكثير من الحيوانات بل هو مضطر إلى اصلاحهما، واصلاحُ ذلك يحوجه إلى آلاتٍ غير مفروغ منها، والإنسان الواحد لا توصل له إلى إعداد جميع ما يحتاج إليه ليعيش العيشة الحميدة، فلم يكن بُدُّ الناس من تشارك وتعاون، فجعل لكل قوم صنعة وهيئة مفارقة للصنعة الأخرى ليقتسموا الصناعات بينهم، فيتولى كلٌّ منهم صنفاً من الصناعات فيتعاطاه باهتزاز، كما قال الله تعالى: (فتقطعوا أمرهم بينهم زُبراً كلُّ حزب بما لديهم فرحون). فاقتضت الحكمة أن تختلف جثثهم وقواهم وهممهم، فيكون كلٌّ ميسرٌّ لما خلق له. وقال تعالى: (قل كلٌّ يعمل على شاكلته). فتكون معايشهم مقتسمة بينهم، كما نبه الله عليه بالآيات المتقدمة. وقال تعالى: (ولو شاءَ ربك لجعل الناس أُمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك). والاختلاف الحاصل بيِّنٌ. فالناس إذا اعتبر اختلاف أغراضهم وهممهم فهم في صناعاتهم في حكم المسخرين وإن كانوا في الظاهر مختارين. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتعلق من المصلحة بتباينهم واختلاف طبقاتهم فقال: " لا يزالُ الناس بخيرٍ ما تباينوا فإذا تساووا وهلكوا " .الباب الثالث عشر
في
سبب تفاوت الناس أسباب ذلك سبعة أشياء: الأول اختلاف الأمزجة وتفاوت
الطينة واختلاف الخلقة، كما أشير فيما روي أن الله تعالى لما أراد خلق آدم
عليه السلام أمر أن يؤخذ من كل أرض قبضةٌ، فجاء بنو آدم على قدر طينتها
الأحمر والأبيض والأسود والسهل والحزْنُ والطيب والخبيث، وإلى نحو هذا
أشار الله تعالى بقوله: (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خَبُثَ
لا يخرج إلاّ نكدا). وقال تعالى: (هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء)
والثاني اختلاف أحوال الوالدين في الصلاح والفساد، وذلك أن الإنسان قد يرث
من أبويه آثار ما هما عليه من جميل السيرة والخلق وقبيحهما، كما يرث
مشابهتَهُما في خلقهما، ولهذا قال الله تعالى: (وكان أبوهما صالحا). وعلى
نحوه روي أنه قال التوراة " إِني إذا رضيتُ باركتُ وإِن بركتي لتبلغ البطن
السابع وإذ سَخِطْتُ لعنتُ وإِن لعنتي لتبلغ البطن السابع " تنبيهاً على
أن الخير والشر الذي يكسبه الإنسان ويتخلق به يبقى أثره موروثاً إلى البطن
السابع. والثالث اختلاف ما تتكوَّن منه النطفة التي يكون منها الولد، ودم
الطمث الذي يتربى به الولد، فذلك له تأثيرٌ بحسب طيب ما تكونا منه وخبثه،
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " تخيروا لنطفكم " وقال: " الناكح غارس
فلينظر أحدكم أين يضع غرسه " وقال: " إياكم وخضراء الدّمن، قيل وما خضراءُ
الدمن قال: " المرأة الحسناءُ في المنبت السوء " والرابع اختلاف ما يتفقد
به من الرضاع ومن طيب المطعم الذي يتربى به، ولتأثير الرضاع يقول العرب
لمن تصفه بالفضل: " لله درُّه " والخامس اختلاف أحوالهم في تأديبهم
وتلقينهم وتطبيعهم وتعويدهم العادات الحسنة والقبيحة، فحق الولد على
الوالدين أن يؤخذ بالآداب الشرعية وأخطار الحق بباله وتعويده فعل الخير
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " مُروهم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر "
ويجب أن يصان عن مجالسة الأردياء، فإنه في حال صباه كالشمع يتشكل بكل شكل
يُشكل به، وأن يحسن في عينه المدح والكرامة ويقبح عنده الذم والمهانة،
ويبغض إليه الحرص على المآكل والمشارب، ويعود الاقتصاد في تناولها ومخالفة
الشهوة ومجانبة ذوي السخف، ويؤخذ بقلة النوم في النهار، فهو يشيب ويورث
الكسل ويعود التأني في أفعاله وأقواله، ويمنع من مفاخرة الأقران ومن الضرب
والشتم والعبث والاستكثار من الذهب والفضة، ويعوِّد صلة الرحم وحسن تأدية
فروض الشرع. قال بعض الحكماء: " من سعادة الإنسان أن يتفق له في صباه من
يعوّده تعاطي الشريعة حتى إذا بلغ الحلم وعرف وجوبها فوجدها مطابقة لما
تعوده قويت بصيرته ونفذت في تعاطيها عزيمته " والسادس اختلاف من يتخصص به
ويخالطه، فيأخذ طريقته فيما يتمذهب به (عن المرءِ لا تسأل وابصر قرينه)
والسابع اختلاف اجتهاده في تزكية نفسه بالعلم والعمل حين استقلاله بنفسه.
والفاضل التام الفضيلة من اجتمعت له هذه الأسباب المسعدة. وهو أن يكون طيب
الطينة معتدل الأمزجة جارياً في أصلاب آباءٍ صالحين ذوي أمانة واستقامة،
متكوناً من نطفة طيبة ومن دم طمث طيب على مقتضى الشرع، ومرتضعاً بدَرٍ طيب
ومأخوذاً في صغره من قبل مربيه بالآداب الصالحة وبالصيانة عن مصاحبة
الأشرار، ومتخصصاً بعد بلوغه بمذهب حق ومجهداً نفسه في تعرف الحق مسارعاً
إلى الخير. فمن وُفق في هذه الأشياء تنجع فيه الخيرات من جميع الجهات كما
قال الله تعالى: (لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم). ويكون جديراً أن يعد
ممن وصفه الله تعالى بقوله: (وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار). والرذل
التام الرذيلة هو من يكون بعكس هذا في الأمور التي ذكرناها.
واعلم أن
من طابت أحواله انتفع بكل ما سمعه وشاهده أن خيراً وأن شراً، ومن خبثت
أحواله استضر بكل ما سمعه وشاهده. وعلى ذلك دلَّ الله تعالى بقوله:
(والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً). فالخبيث
من الأرض وإن طاب بذره وعذب ماؤه لا ينبت إلاّ خبيثاً، والطيب من الأرض
وإن كدر بذره وملح ماؤه لا ينبت إلاّ طيباً، ولذلك قال يسبحانه وتعالى في
كتابه: (تسقى بماءٍ واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل) وقال في صفة
كتابه: (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاؤٌ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرٌ
عليهم عمىّ).
الباب الرابع عشر
في بيان الشجرة النبوية
وفضلها على جوهر سائر البرية اقتضت الحكمة ان تكون الشجرة النبوية صنفاً
مفرداً ونوعاً واحداً واقعاً بين الإنسان والملَك، ومشاركاً لكل واحد
منهما على وجهٍ، فإنهم كالملائكة في اطلاعهم على ملكوت السموات والأرض،
وكالبشر في احوال المطعم والمشرب. ومثَلُه في كونه واقعاً بين نوعين مثل
المرجان فإنه حجر يشبه الأشجار بتشذّب اغصانه، وكالنخل فإنه شجر شبيه
بالحيوان في كونه محتاجاً الى التلقيح وبطلانه اذا قطع رأسه. وجعل الله
النبوة في ولد ابراهيم ومن قبله نوح كما نبه عليه بقوله: (ولقد ارسلنا
نوحاً وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب) وقال تعالى: (ذرية
بعضها من بعض). فهم عليهم السلام وان كانوا من حيث الصورة كالبشر، فهم من
حيث الأرواح كالملَك قد أُيّدوا بقوةٍ روحانيةٍ وخُصّوا بها كما قال الله
تعالى في عيسى عليه السلام: (وايدناه بروح القدس) وقال في محمد صلى الله
عليه وسلم: (نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي
مبين). وتخصيصهم بهذا الروح ليمكنهم ان يقبلوا من الملائكة لما بينهم من
المناسبة البشرية لذلك قال سبحانه: (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا
ولَلَبَسْنَا عليهم ما يلبسون) تنبيهاً على ان ليس في قوة عامة البشر
الذين لم يخصوا بذلك الروح ان يقبلوا الاَّ من البشر. ولما عمي الكفار عن
ادراك هذه المنزلة وعما للأنبياء من الفضيلة انكروا نبوة الأنبياء كما قال
الله تعالى: (قالوا ان انتم الا بشرٌ مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد
آباءُنا فأتونا بسلطان مبين). فالأنبياء صلوات الله عليهم بالإضافة إلى
سائر الناس كالإنسان بالإضافة إلى الحيوانات، وكالقلب بالإضافة إلى سائر
الناس كالإنسان بالإضافة إلى الحيوانات، وكالقلب بالإضافة إلى سائر
الجوارح، وأيضاً فمنزلة الأنبياء من أُممهم بمنزلة الشمس من القمر، ومنزلة
علمهم من علوم أممهم بمنزلة ضوء الشمس من نور القمر كما قال الله تعالى:
(هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً). فكما أن نور القمر مقتبس من ضوء
الشمس وهو قاصر عنها، كذلك منزلة الأُمم من أنبيائهم ومنزلة علمهم من
علومهم. وكما لا يحصل النور للقمر إلاّ بوساطة الشمس، كذلك لا تحصل علوم
الناس وتزكية نفوسهم إلاّ بوساطة الشمس، كذلك لا تحصل علوم الناس وتزكية
نفوسهم إلاّ بوساطة الأنبياء، وعلى هذا دل الله تعالى بقوله: (ربنا وابعث
فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك
أنت العزيز الحكيم). فالله تبارك وتعالى يزكي الأنبياء بوساطة الملك،
ويزكي من يشاء من الناس بوساطة الأنبياء، كالطابع الذي جعل له كتابة ثم
بوساطته يثبت في الشموع المختلفة شكل تلك الكتابة.
الباب الخامس عشر
في هداية الأشياء إلى مصالحهاكل
ما أوجده الله سبحانه فإنه هداه لما فيه مصلحته، كما نبه عليه بقوله
تعالى: (أعطى كل شيءً خلقه ثم هدى). لكن هدايته للجمادات بالتسخير فقط
كالأشياء الأرضية التي إذا تركت تنحو نحو السفل وكالنار التي تنحو إلى
العلو. وهدايته للحيوانات إلى أفعال تتعاطاها بالتسخير والإلهام كالنحل
فيما يتعاطى من السياسة واتخاذ البيوت المسدسة ومن عمل العسل. وكالسُّرفة
فيما تبنيه من الأبنية. وكالعنكبوت في نسجه. وهدايته للملائكة بالتسخير
والإلهام وببداهة العقل وما جعل لها من العلوم الضرورية، فأما الإنسان
فهدايته له تعالى بكل ذلك وبالفكر، وذلك أنه بالتسخير بنفسه وكثير من
حركاته، وبإلهام هدايته طفلا للارتضاع بالثدي وطلب الغذاء والتشكي من
الآلام بالبكاء، وببديهية العقل يعرف مبادي العلوم، وبالفكر يتوصل إلى
استنباط المجهول بالمعلوم، فهو إن خلق عارياً من المعارف التي جعلها الله
تعالى للحيوانات بالإلهام، ومن الملابس والأسلحة التي جعلها لها بالتسخير،
فقد جعل للإنسان قوة التعلم بالعقل والفكر وتحصيل الملابس والأسلحة
والآلات المختلفة، ووكله إلى نفسه من الإستفادة، ومكنه من ذلك، وذلك فضيلة
لا نقيصة ورفعة لا ضعة فإنه بإعطائه العلم والعقل واليد العاملة قد أعطاه
كل شيءٍ، ولو أُعطي كل شيءٍ حسب ما أعطي البهائم شيئاً فشيئاً لكان قد منع
كلَ شيءٍ لأن بعضه كان يمنعه عن استعمال البعض. وإلى تمكن الإنسان من
تحصيل ما يريده أشار الله تعالى بقوله: (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا
تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) وقد ظن قوم
أن الله تعالى خلق الناس من بين الحيوان خلقاً منقوصاً إذ لم يعطوا سلاحاً
يدفعون به عن أنفسهم كما أعطى كثيراً من الحيوان أسلحة كالأنياب والمخالب،
إذ لم يكفهم لباسهم كما كفى الحيوان بل قد أحوجهم إلأى تطهير البدن وقد
أغناها عنه، قالوا ولذلك قال الله تعالى: (وخُلق الإنسان ضعيفاً). وليس
كذلك والصحيح عند المخلصين أن الإنسان وإن كان ضعيفاً بالإضافة إلى الباري
تعالى وإلى الملإِ الأعلى فليس يقصر عن الحيوان جميعه من جهة ما ظنوه، فإن
الله تعالى بحكمته البارعة أعطى كل واحد من الحيوان سلاحاً بقدر ما علم من
مصلحته، فبعض جعل له آلة الهرب كالعدو، وبعض جعل له رمحا يدفع به كالقرون
للبقر والغنم، وبعض دبوساً كالحافر للفرس والحمار، وبعض نشاباً كالشوك
للقنفذ، وجعل لكلٍ لباساً بحسب كفايته، وألهم كلاً منها صنعة يتعاطاها
بطبعه، وجعل للإنسان بدل ذلك الفكر والتمييز الذي يمكنه أن يتخذ به كل آلة
وكل ملبس على قدر حاجته إليه، ويتناوله متى شاء، ويضعه متى أحب، ويستبدل
به كيفما أراد، والحيوانات ليس لها أن تضع أسلحتها متى ما استغنت عنها ولا
أن تستبدل بها فهذا دليل على تمام الإنسان ونقصان الحيوانات، والإنسان
بالفكر والرويّة يقهر الحيوانات التي هي أقوى منه لأنه يهيء بفكرته لكل
منها آلة يصطادها بها. فإذاً العقل الذي أعطاه ليحصل به كل ما يحتاج إليه
أعلى وأشرف، فإنه مرآة إذا جلاها اطّلع بها على ملكوت السموات والأرض.
الباب السادس عشر
في سعادة الإنسان ونزوعه إليها قال بعض الحكماء: جعل الله لكل شيء كمالاً ينساق إليه طبعا، وقد هداه إلى التخصيص به تسخيراً، كما نبه الله عليه بقوله تعالى: (أعطى كل شيء خلقه ثم هدى). وللإنسان سعادات أتيحت له وهي النعم المذكورة في قوله تعالى: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) وجميع النعم والسعادات على القول المجمل ضربان ضرب دائم لا يبيد ولا يحول وهو النعم الأُخروية. وضرب يبيد ويحول وهو النعم الدنيوية. والنعم الدنيوية متى لم توصلنا إلى تلك السعادات فهي كسراب بقيعة وغرور وفتنة وعذاب كما وصفه الله تعالى في كتابه: (إنما مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماءِ.. الآية). وما أصدق ما قال الشاعر:إِنما الدنيا كرؤيا أفرحت ... من رآها ساعةً ثم انقضت
فصل
ما
أحد إلا وهو فازع إلى السعادة يطلبها بجهد ولكن كثيرا ما يخطيءُ فيظن ما
ليس بسعادة في ذاته أنه سعادة فيغتر بها فيكون كالموصوف بقول الله تعالى:
(والذين كفروا أعمالُهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً حتى إذا جاءه لم
يجده شيئاً). وبقوله تعالى: (أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يومٍ عاصف
لا يقدرون مما كسبوا على شيء) وقال الشاعر:
كلٌ يحاول حيلة يرجو بها ... دفع المضرة واجتلاب المنفعة
والمرء يغلط في تصرف حاله ... فلربما اختار العناء على الدعة
فصل
النعم الدنيوية إنما تكون نعمة وسعادة متى تُنُو ولت على ما يجب وكما يجب، ويجري بها على الوجه الذي لأجله خُلق، وذلك أن الله جعل الدنيا عارية ليتناول منها قدر ما يتوصل به إلأى النعم الدائمة والسعادة الحقيقية. وشرع لنا، في كل منها حكما بيَّن فيه كيف يجب أن يتناول ويتصرف فيها لكن صار الناس في تناولها فريقين: فريق يتناوله على الوجه الذي جعله الله لهم فانتفعوا به، فصار ذلك لهم نعمة وسعادة وهم الموصوفون بقوله تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) وقوله عز وجل: (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين) وقوله تعالى: (والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوأنهم في الدنيا حسنة). فهؤلاء حيوا بها حياةً طيبة كما قال تعالى: (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حياةً طيبة) وفريق يتناولوها لا على الوجه الذي جعلها الله لهم، فركنوا إليها فصار ذلك لهم نقمة وشقاوة، فتعذبوا بها عاجلاً وآجلاً وهم الموصوفون بقوله تعالى: (إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون).فصلوالسعادات الأُخروية ليس لنا تصور كنهها ما دمنا في دار الدنيا ولذلك قال تعالى: (فلا تعلم نفسٌ ما أُخفي لهم من قرة أعين). وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تعالى " أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أُذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر " والسبب في قصورنا عن تصورها شيئان: أحدهما أن الإنسان لا يمكن أن يعرف حقيقة الشيء وتصوره حتى يدركه بنفسه، وإذا لم يدركه ووصف له يجري مجرى صبيّ توصف له لذة الجماع فلا يمكن أن يتصور حقيقته حتى يبلغ فيباشره بنفسه. وكالأكمه توصف له المرآة. وحالنا في اللذة الأُخروية هكذا فإننا لا نتصورها على الحقيقة إلا إذا طالعناها فإذا طالعناها شغلنا الفرح والتلذذ بها عن كل ما دونها كما قال تعالى: (أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون). والثاني أن لكل قوة من قوى النفس وجزءاً من أجزاءِ البدن لذة تختص بها لا يشاركها فيها غيرها، فلذة العين في النظر إلى ما تستحسنه، ولذة السمع في الإستماع إلأى ما يستطيبه، ولذة اللمس في لمس ما يستلذه، ولذة لوهم في تصور ما يؤمله، ولذة الخيال في تخيل ما يستحسن تصوره، ولذة الفكر في أمر مجهول عنده يتعرفه، وكل واحد من هذه القوى والأجزاءِ إذا عرض لها آفة تعوقها عن شهوتها وعن إدراك لذتهايكون كالمريض الذي لا يشتهي الماء وكان به ظمأ وإذا تناوله لم يجد له لذة كما قال الشاعر:
ومن يك ذا فم مر مريض ... يجد مرّا به الماء الزلالا
وإذا
كان كذلك فاللذات الأُخروية هي لذات لا تدرك إلا بالعقل المحض وعقول أكثر
من في هذه الدار مولهة معوقة عن إدراك حقائق اللذات الأخروية فلا تشعر بها
كالخدر لآفة عرضت له فلا يحس بالسبب المؤلم. وكالمريض الذي لا يحس بالجوع
وإن كان جوعه يؤذيه، ولا يشتهي الطعام إن كان فقد الطعام يضنيه، بل إنما
يحس بالجوع إذا زال السبب المؤلم. وأيضاً فعقول أكثرنا ناقصة وجارية مجرى
عقول الصبيان ما داموا صغاراً لا يحسون باللذات والآلام التي تعرض للرجال
فيتعللون بالأباطيل والأضاليل، كذلك من كان في عقله صبياً لم يطلع على
الحقائق وبالاعتبار بهم قال الله تعالى: (وما هذه الحياة الدنيا الاّ لهوٌ
ولعب) وقال تعالى: (فلا تغرنَّكم الحياة الدنيا ولا يغرنَّكم بالله
الغرور) ولما أراد الله تعالى أن يقرّب معرفة تلك اللذات من أفهام الكافة
شبهَّها ومثَّلها لهم بأنواع ما تدركها حواسهم فقال تعالى: (مثَل الجنة
التي وُعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهارٌ من لبن لم يتغير
طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى). ليبين للكافة طيبها
بما عرفوه من طيب المطاعم وقال: (مثل الجنة التي وُعد المتقون). ولم يقل
الجنة لينبه الخاصة على أن ذلك تصوير وتمثيل، فالإنسان وإن اجتهد ما اجتهد
أن يطلع على تلك السعادة فلا سبيل له إليها إلاّ على أحد وجهين: أحدهما أن
يفارق هذا الهيكل، ويخلّف وراءَه هذا المنزل فيطلع على ذلك كما قال الله
تعالى: (يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل
أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا وإنا منتظرون). والثاني أن يزيل قبل
مفارقة الهيكل الأمراض النفسانية المشار إليها بوله تعالى: (في قلوبهم مرض
فزادهم الله مرضاً) وأرجاسها المشار إليها بقوله تعالى: (إنما يريد الله
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) فيطلع من وراءِ ستر رقيق على
بعض ما أعد له كما حكي عن حارثة حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم عزفت
نفسي من الدنيا فكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً وأطلع على أهل الجنة
يتزاورون وعلى أهل النار يتعاوَوْن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "
عرفت فالزم " وقال أمير المؤمنين عليٌّ عليه السلام: " لو كُشف الغِطاء ما
ازددتُ يقيناً " .
الباب السابع عشر
في حالة الإنسان في دنياه وما يحتاج أن يتزود منها الإنسان مسافر ومبدأ سفره من حيث ما أشار إليه تعالى بقوله: (وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين). وحيث قال في صفة نبيه: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى). ومنتهى سفره دار السلام ودار القرار. وله في سفره أربعة منازل ظهر أبيه وبطن أمه وظهر الأرض والموقف، وله حالتان حالة هو فيها مستودع وهو ما دام في هذه المنازل، وحالة هو فيها مستقرٌ وهو إذا حصل في دار القرار وإلى ذلك أشار الله تعالى بقوله: (وهو الذي أنشأكم من نفسٍ واحدة فمستقر ومستودع). والمنزل الذي فيه يحتاج إلى تزود ظهر الأرض فالإنسان في كدح وكبد ما لم ينته إلى دار القرار كما قال الله تعالى: (يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه). وقال تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في كَبد). وهو مجبول على طلب الراحة لكن الناس في طلبها على ضربين ضرب عموا عن الآخرة وقالوا: (وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا) أو فعلوا فعل من قال ذلك وإن لم يقولوا قولهم، فطلبوا الراحة من حيث لا راحة وهم كالموصوفين بقوله عز وجل: (والذين كفروا أعمالُهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً) وقوله: (إنما مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض..) الآية. فإنهم طلبوا من الدنيا ما ليس في طبيعتها ولا موجوداً فيها ولها. وما أحسن قول الشاعر:أريد من زمني ذا أن يبلغني ... ما ليس يبلغه في نفسه الزمن
وقال آخر:
مضى قبلنا قوم رجوا أن يقوموا ... بلا تعب عيشاً فلم يتقوّمِ
وضرب
عرفوا الدنيا والآخرة وعلموا أن الدنيا كما قال الله تعالى: (ولكم في
الأرض مستقر ومتاع إلى حين وإن الدار الآخرة لهي الحيوان). وعلمواأن فيها
يستقر الإنسان ويطمئن كما قال الله تعالى: (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي
إلى ربك راضية مرضية). وإنه يحتاج إلى أن يسافر إليها كما قال عليه
السلام: " سافروا تغنموا " . فاحتملوا المشقة، علماً أن كل تعب يؤديهم إلى
راحة فهو راحة فسعدوا كما قال الله تعالى: (وأما الذين سعدوا ففي الجنة).
وقد
جعل للإنسان حرثين مفيدين لزادين: احدهما روحاني كالمعارف والحكم
والعبادات والاخلاق الحميدة، وثمرته الحياة الابدية والغني الدائم،
والاستكثار منه محمود ولا يكاد يطلبه الاَّ من قد عرفه وعرف منفعته.
والثاني جسماني كالمال والاثاث، وفي الجملة ما قد نبه الله تعالى عليه
بقوله: (زُين للناس حبُّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من
الذهب والفضة والخيل المسوَّمة والانعام والحرث). وثمرته ان تحصل به
الحياة الدنيوية الفانية، ويسترجع من الإنسان اذا فارق دنياه، ولا ينتفع
منه بشيء الاَّ بقدر ما أستعان به في الوصول إلى الزاد الأُخروي كما نبه
الله تعالى عليه بقوله: (وما الحياة الدنيا في الآخرة الاَّ متاع). ولا
يولع بالركون اليها الا من جهل حقائقها ومنافعها. والاستكثار منه ليس
بمذموم ما لم يكن مثبطاً لصاحبه عن مقصده، وكان متناولاً على الوجه الذي
يجب وكما يجب، ومجعولاً الى الوجه الذي ينتفع به في مقصده، لكن تناوله على
هذا الوجه والاستكثار منه لا يتأتى الاَّ اذا كان السلطان عادلاً والامور
جارية على أَذلالها فيحفظ الناس معاملاتهم على مقتضى الشرع، ثم يكون صاحبه
اذا تناوله كما قال تعالى: (ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أُوتوا ويؤثرون
على انفسهم ولو كان بهم خصاصة). فاذا لم يكن الامر كما ذكرنا من الاستقامة
فليس الا الاقتصاد والاقتصار والتبلغ بما امكن حتى ينقضي السفر. الموفق في
الدنيا اذا رأَى نفسه قاصرة عن الجمع بين الامرين اهتم بما يبقى واقل
العناية بما يفني وآثر الآخرة على الدنيا فلا يلتفت إلى الدنيا الاَّ بقدر
ما يتبلغ به إلى الآخرة مراعياً فيه حكم الشرع ومحافظاً لقول الله عز وجل:
(يا ايها الناس ان وعد الله حقٌّ فلا تغرنَّكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم
بالله الغرور) وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما انا والدنيا انما
مَثَلي فيها مثل راكب سار في يوم صائف فرفعت له شجرة فنزل فقام في ظلها
ساعة ثم راح وتركها " . وقد نبه الله تعالى على حال من يريد ان يتجرد
ويتخلص من حبالة الدنيا على سبيل المثال بقوله: (ان الله مبتليكم بنَهر
فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني الا من اغترف غرفة بيده).
ومحبة الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس كل خطيئة.وقد روي عنه
صلى الله عليه وسلم: " من سكن قلبه حبُّ الدنيا بثلاثةٍ شغلٍ لا يبلغ
مَداه وفقر لا يبلغ غناه وامل لا يبلغ منتهاه " . وقال صلى الله عليه
وسلم: " من كانت الدنيا اكبر همه فرَّق الله تعالى همته وجعل فقره بين
عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له ومن كانت الآخرة اكبر همه جمع
الله تعالى شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة " وهذا معنى
قوله عز وجل: (من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من
نصيب) ومعرفة ذلك والوصول اليه لا يمكن الا ان يستضيء العقل بنور الشرع
معتمداً على من له الخلق والأَمر.
الباب الثامن عشر
في تظاهر العقل والشرع وافتقار احدهما إلى الآخراعلم
ان العقل لن يهتدي الا بالشرع، والشرع لا يتبين الا بالعقل، فالعقل
كالأُس، والشرع كالبناء، ولن يغني اسٌّ ما لم يكن بناءٌ، ولن يثبت بناءٌ
ما لم يكن اسٌ. وايضاً فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع ولن يغني البصر ما لم
يكن شعاع من خارج ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر ولهذا قال الله تعالى:
(قد جاءَكم من الله نورٌ وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سُبُل
السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإِذنه). وايضا فالعقل كالسراج
والشرع كالزيت الذي يمده، فإن لم يكن زيت لم يحصل السراج، وما لم يكن
سراج، لم يضئ الزيت. قال الله تعالى: (الله نور السموات والارض مثَلُ نوره
كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكبٌ دريٌّ يوقد من
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
نورٌ على نور يهدي الله لنوره من يشاء). والله هو الهادي. وايضاً فالشرع
عقل من خارج، والعقل شرع من داخل، وهما متعاضدان بل متحدان ولكون الشرع
عقلاً من خارج سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر في غير موضع من القرآن
نحو قوله: (نورٌ على نور) أي نور الشرع ونور العقل ثم قال: (يهدي الله
لنوره من يشاء). فجعلهما نوراً واحداً فالشرع اذا فُقد العقلُ عجز عن اكثر
الأمور عجزَ العين عند فقد الشعاع.
واعلم ان العقل بنفسه قليل الفناء
لا يكاد يتوصل الاَّ الى معرفة كليات الأَشياء دون جزئياتها؛ نجو ان يعلم
جملة حسن اعتقاد الحق وقول الصدق وتعاطي الجميل وحسن استعمال العدالة
وملازمة العفة ونحو ذلك من غير ان يعرف ذلك في شيءِ شيءٍ وما الذي هو
معدلةٌ في شيءِ شيءٍ ولا يعرفنا العقل مثلاً ان لحم الخنزير والدم والخمر
محرم، وانه يجب ان يتحامى من تناول الطعام في وقت معلوم، وان لا تنكح ذوات
المحارم، وان لا تجامع المرأة في حال الحيض فإ اشباه ذلك لا سبيل اليها
الا بالشرع فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة والافال المستقيمة والدال على
مصالح الدنيا والآخرة، ومن عدل عنه فقد ضلَّ سواء السبيل. ولأجل ان لا
سبيل للعقل الى معرفة ذلك قال الله تعالى: (وما كنمعذّبين حتى نبعث
رسولا). وقد قال الله تعالى: (ولو أنا اهلكناهم بعذاب من قله لقالوا ربنا
لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى). والى العقل
والشرع اشار بالفضل والرحمة بقوله تعالى: (ولولا فضل الله ليكم ورحمته
لأتبعتم الشيطان الا قليلا). وعني بالقليل المصطفين الاخيار.
الباب التاسع عشر
في فضيلة الشرع اعلم ان احكام الشرع من وجه دواءٌ ومعجون مفروغ منه تولى ايجاده مَنْ له الخلق والأمر. وهو دواءٌ مفيد للحياة الأبدية والسلامة الدائمة كما قال الله تعالى: (أَوَ من كان ميّتاً فأحييناه) وقال تعالى: (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم). فجعل ذلك روحاً لإفادة الحياة الأبدية. وقال الله تعالى: (قل هو للذين أمنوا هدى وشفاءٌ). وقوله: (شفاءٌ لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤّ منين).ومن وجهٍ هو ماءٌ مطهر مزيل للأنجاس والأرجاس النفسية كما قال الله تعالى في وصفه للقرآن: (أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً). وكذلك قال الله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب الرجس عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا). ومن وجه ٍ هو نورٌ وسراجٌ مزيل للظلمة والحيرة والجهالة قال الله تعالى:(قد حائكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم) وقوله تعالى: (الله نور السموات والأرض). ومن وجهٍ وسيلةٌ إلى الله عز وجل كما قال: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة). وقال فيمن مدحهم: (يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيُّهم أقرب ويرجون رحمته) وقوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً) وقوله تعالى: (فليتفرقوا في الأسباب). ومن وجهٍ هو الطريق المستقيم كما قال الله تعالى: (وإن هذا صراطي مستقيماً).فصل
ذكر بعض الحكماء أن
الأرض المقدسة المذكورة في قوله تعالى: (يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم). هي في الدنيا الشريعة وفي الآخرة
الجنة لأنها هي التي إذا دخلها الإنسان لا يرتد على دُبُره ونال السعادة
الكبرى بلا مثنوية. فأما بيت المقدس في الأرض فإن من يدخله فبنفس دخوله
إياه لا يستحق مثوبة بل المثوبة تستحق بأُمور أُخر يكون دخوله المكان الذي
هو بيت المقدس آخرها بعد أن يكون دخوله على وجه مخصوص. قال وعلى هذا الحرم
المذكور في قوله تعالى: (أو لم يروا إنا جعلنا حَرماً آمناً ويتخطف الناس
من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون). وسأل جعفر بن محمد
الصادق بعض الفقهاء عن هذه الآية فقال أُريد بها مكة فقال: " وا عجبا
وأيُّ أرض أكثر تخطفاً لمن حولها من مكة. ويدل على ما قال قول الله تعالى
بعد ذلك: (وما أوتيتم من شيءٍ فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله
خير وأبقى أفلا تعقلون) وكذلك قوله تعالى: (وإذا قيل لهم أسكنوا هذه
القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سُجَّداً نغفر لكم
خطاياكم وسنزيد المحسنين). والسفر الموعود بالغنيمة بقول النبي صلى الله
عليه وسلم: " سافروا تغنموا " هو السفر إلى هذه الدار. وكذلك القرار
المدّعو إليه من جهة المثل بقوله ففرُّوا إلى الله. وكذا الحج الأكبر الذي
دعا الناس إليه بقوله: (وأذانٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر)
وقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وكذا الجهاد
الأعظم في قوله تعالى: (وجاهِدوا في الله حقَّ جهادِهِ) والهجرة الكبرى في
قوله تعالى: (أَلم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها).
الباب العشرون
في أن من لم يختص بالشرع وعبادة الله فليس بإنسانلما كان الإنسان إنما يصير إنساناً بالعقل، ولو توهمنا العقل مرتفعاً عنه لخرج عن كونه إنساناً، ولم يكن إذا تخطينا الشبح الماثل الاّ بهيمة مهملة أو صورة ممثلة. والعقل لن يكمل بل لا يكون عقلاً إلا بعد اهتدائه بالشرع كما تقدم ولذلك نفي العقل عن الكفار لما تعرّوا عن الهداية بالشرع في غير موضع من كتابه، والاهتداء بالشرع هو عبادة الله تعالى. فالإنسان إذاً في الحقيقة هو الذي يعبد الله ولذلك خُلقَ كما قال الله تعالى: (وما خلقتُ الجن والإنس إلاّ ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون). وكما قال تعالى: (وما أُمروا إلاّ ليعبدوا الله مخلصينَ له الدين) فكلُّ ما أُوجد لفعل فمتى لم يوجد منه ذلك الفعل كان في حكم المعدوم، ولذلك كثيراً ما يسلب عن الشيءِ اسمه إذا وجد فعله ناقصاً، كقولهم للفرس الرديء: ليس هذا بفرس وللإنسان ليس هذا بإنسان. ويقال: فلان لا عين له ولا أُذن له إذا بطل فعل عينه وأُذنه وإن كان شبحهما باقياً، وعلى هذا قال تعالى: (صمٌ بكمٌ عميٌ). فيمن لم ينتفع بهذه الأعضاء فالإنسان يحصل له من الإنسانية بقدر ما يحصل له من العبادة التي لأجلها خُلق، فمن قام بالعبادة حق القيام فقد استكمل الإنسانية، ومن رفضها فقد انسلخ من الإنسانية فصار حيوانا أو دون الحيوان كما قال الله تعالى في وصف الكفار: (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلُّ سبيلا). وقال: (ان شر الدواب عند الله الصمُّ البكُم الذين لا يعقلون). فلم يرضَ ان يجعلهم أنعاماً ودواب حتى جعلهم أضلَّ منها وجعلهم من أشرارها، وأخرج كلامهم عن جملة البيان فقال تعالى: (وما كان صلاتهم عند بيت إلا مُكاءً وتَصْدِيَة) تنبيها على انهم كالطيور التي تمكو وتُصَدّي ونبه تعالى بنكتة لطيفة على أن الإنسان لا يكون إنساناً إلاَّ بالدين ولا ذا بيان إلا بقدرته على الإتيان بالحقائق الدينية فقال تعالى: (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان) فابتدأ بتعليم القرآن ثم بخلق الإنسان ثم بتعليم البيان، ولم يدخل الواو فيما بينهما وكان الوجه على متعارف الناس أن يقول خلق الإنسان وعلمه البيان وعلمه القرآن، فان إيجاد الإنسان بحسب نظرنا مقدم على تعليم البيان وتعليم البيان مقدم على تعليم القرآن، لكن لما لم يُعَد الإنسان إنسانا ما لم يتخصص بالقرآن ابتدأ بالقرآن، ثم قال خَلق الإنسان تنبيهاً على ان بتعليم القرآن جعله إنساناً على الحقيقة، ثم قال علمه البيان تنبيهاً على ان البيان الحقيقي المختص بالإنسان يحصل بعد معرفة القرآن فنبه بهذا الترتيب المخصوص وترك حرف العطف منه وجعل كل جملة بدلاً مما قبلها لا عطفاً على إن الإنسان ما لم يكن عارفاً برسوم العبادة ومتخصصاً بها لا يكون إنساناً، وان كلامه ما لم يكن على مقتضى الشرع لا يكون بياناً. فإن قيل فعلى ما ذكرته لا يصح أن يقال للكافر إنسان وقد سماهم الله بذلك في عامة القرآن. قيل انا لم نقل إنا لا نسمي الكافر على تعارف الكافة، بل قلنا قضية العقل والشرع تقتضي أن لا يسمى به إلا مجازاً ما لم يوجد منه العقل والشرع تقتضي أن لا يسمى به إلا مجازاً ما لم يوجد منه العقل المختص به، ثم أن سمي به على سبيل تعارف العامة فليس ذلك بمنكر فكثير من الأسماء يستعمل على وجه فيبين الشرع أن ليس استعماله على ما استعملوه كقولهم الغنيُّ فإِنهم استعملوه في كثرة المال، وبيَّن الشرع أن الغنى ليس هو بكثرة المال، قال عليه الصلاة والسلام: " ليس الغني بكثرة المال وإنما الغني غنى النفس " . فيشير إلى أن الغنى ليس هو كثرة المال. وقال تعالى (ومن كان غنياً فليستعفف). أي كثير الأعراض، فاستعمله على ما هو متعارف. وجملة الأمر أن اسم الشيء إذا أطلقه الحكيم على سبيل المدح يتناول الأشرف منه كقوله تعالى: (وأنه لَذكرٌ لك ولقومك) وقوله تعالى: (ورفعنا لك ذكرك) وإن كان الذكر قد يقال للمحمود والمذموم. وعلى هذا يمدح كل شيء بلفظ نوعه، فيقال: فلان هو إنسان. وهذا السيف سيف. ولهذا قيل: الإنسان المطلق هو نبي كل زمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: " الناس اثنان عالم ومتعلم وما عداهما هَمَج " . وقال بعض العلماء: قول من قال الإنسان هو الحي الناطق الميت صحيح. وليس معناه مل توهمه كثير من الناس من أنه من الحياة الحيوانية والموت الحيواني والنطق الذي هو في الإنسان بالقوة
وإنماما
أريد بالحي من كان له الحياة المذكورة في قوله تعالى: (لينذر من كان
حياً). وبالنطق البيان المذكور بقوله: (علمه البيان) وبالميت من جعل قوته
الشهوانية الغضبية مقهورتين على مقتضى الشريعة فيكون حينئذ ميتاً بالإرادة
حياً بالطبيعة كما قيل: مت بالإرادة تحيَ بالطبيعة. كما قال أمير المؤمنين
عليه السلام: من أمات نفسه في الدنيا فقد أحياها في الآخرة.أريد بالحي من
كان له الحياة المذكورة في قوله تعالى: (لينذر من كان حياً). وبالنطق
البيان المذكور بقوله: (علمه البيان) وبالميت من جعل قوته الشهوانية
الغضبية مقهورتين على مقتضى الشريعة فيكون حينئذ ميتاً بالإرادة حياً
بالطبيعة كما قيل: مت بالإرادة تحيَ بالطبيعة. كما قال أمير المؤمنين عليه
السلام: من أمات نفسه في الدنيا فقد أحياها في الآخرة.
الباب الحادي والعشرون
فيما يتعلق بالشرع من الأفعال للإنسان ضربان من الأحوال لا ينفك منهما، ضرب لا يلحقه فيه محمدةٌ ولا مذمة ولا في جنسه تكليف وذلك شيئان، أحدهما أحوال ضرورية لا يمكنه أن يتفصى منها كنبض العرق والتنفس وما يجري مجراهما من الأحوال الضرورية. والآخر ما يقع من الإنسان على سبيل السهو والخطأ وإن كان جنسه مقدوراً له وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . وضرب تلحقه فيه المحمدة والمذمة وفي جنسه التكليف وذلك ثلاثة أشياء: أحدها الأفعال المختصة بالجوارح كالقيام والقعود والركوب والمشي والنظر وكل ما يحتاج إلى استعمال الأعضاء فيه. والثاني حفظ عوارض النفس كالشهوة والخوف واللذة والفرح والغضب والشوق والرحمة والغيرة وما أشبه ذلك. والثالث ما يختص بالتمييز والعلم. وكل واحد من هذه الثلاثة أما أن يحمد عليه الإنسان أو يذم. فحمده أن تكون أفعاله جميلة وعوارض نفسه مستقيمة وقلبه ذكياً حتى يعتقد الحق ويقوي على معرفته إذا ورد عليه. والمذمة تلحقه إن كانت على أضداد ذلك. والعبادات بهذه الأشياء الثلاثة تختص. ولله تعالى في كل فعل يتحراه الإنسان عبادة سواءٌ كان الفعل واجباً أو ندباً أو مباحاً، وتكون تلك العبادة مبينة أما ببديهة العقل أو بالكتاب أو بلسان النبي أو بإجماع الأمة أو بالاعتبارات والأقيسة المبنية على هذه الأصول بل ما من حكم إلا وكتاب الله ينطوي عليه كما قال الله تعالى: (ما فرَّطنا في الكتاب من شيءٍ). عرفه من عرفه وجهله من جهله. وما من مباح إلا وإذا تعاطاه الإنسان على ما يقتضيه حكم الله تعالى كان الإنسان في تعاطيه عابداً لله مستحقاً لثوابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعدٍ: " إنك لتؤجر في كل شيء حتى اللقمة تضعها في فيّ امرأتك " . ومخاطبته لسعد بذلك لما عرف منه أنه يراعي في أفعاله حكم الله تعالى. وعلى هذا الوجه قال: " ما من غرس غرساً لم يأكل منه شيئاً إلا كان له صدقة " . ومراعاة أمر الله في جميع الأمور دقيقها وجليلها مستحب للكافة وواجب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل من تقرب منزلته من منزلته لقول الله تعالى: (فاستقم كما أمرت ومن تاب معك).الباب الثاني والعشرونفي تحقيق العبادة العبادة فعلٌ اختياريٌ للشهوات البدنية، تصدر عن نية يراد بها التقرب إلى الله تعالى طاعةً للشريعة. فقولنا فعلُ اختياريٌ يخرج منه الفعل التسخيري والقهري ويدخل فيه الترك الذي هو على سبيل الاختيار، فإن الترك ضربان، ضرب على سبيل الاختيار وهو فعل. وضرب هو العدم المطلق لا اختيار معه بل هو عدم الاختيار وليس بفعل. وبقولنا مناف للشهوات البدنية يخرج منه ما ليس بطاعة، وأما الأفعال المباحة كالأكل والشرب ومجامعة المرأة فليس بعبادة من حيث أنها شهوة ولكنها قد تكون عبادة إذا تحري بها حكم الشريعة، وإنما قيل تصدر عن نية يراد بها التقرب إلى الله تعالى لأنها إن خلت عن نية أو صدرت عن نية لم يقصد بها التقرب إلى الله تعالى بل أريد بها مراءاة لم تكن أيضاً عبادة، وإنما قيل طاعة للشريعة لأن من أنشأ من نفسه فعلا ليس بسائغ في الشريعة لم يكن عبادة وإن قصد به التقرب إلى الله تعالى، فالعبادة إذاً فعل يجمع هذه الأوصاف كلها.
الباب الثالث والعشرونفي أنواع العبادة من اعلم والعمل
العبادة
ضربان: علم وعمل. وحقهما أن يتلازما، لأن العلم كالأُس والعمل كالبناء،
وكما لا يغني أُس ما لم يكن بناء، ولا يثبت بناء ما لم يكن أسٌّ، كذلك لا
يغني علم بغير عمل ولا عمل بغير علم، ولذلك قال الله تعالى: (إليه يصعد
الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه). والعلم أشرفهما لكن لا يغني بغير عمل،
ولشرفه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيما الأعمال أفضل يا رسول
الله؟ فقال: " العلم " فأعاد عليه السوال فقال: " العلم " فقال الرجل في
الثالثة: اسألك عن العمل لا عن العلم. فقال عليه السلام: " عمل قليل مع
العلم خير من عمل كثير مع الجهل " وقال عليه السلام: " طلب العلم فريضة
على كل مسلم " . فالعلم ضربان: نظري وعملي، فالنظري ما إذا علم كفى ولم
يحتج فيه بعده إلى عمل كمعرفة وحدانية الله تعالى ومعرفة ملائكته وكتبه
ورسله واليوم الآخر ومعرفة السموات وما أشبه ذلك. والعملي ما إذا عُلم لم
يغن حتى يعمل به كمعرفة الصلاة والزكاة والجهاد والصوم والحج وبرّ
الوالدين. والأعمال ثلاثة أضرب: منها ما يختص بالقلب، ومنها ما يختص
بالبدن، ومنها ما يشارك فيه البدن القلب. والعلم أيضاً إذا نظر إليه وهو
مكتسب فاكتسابه عمل وإذا نظر إليه وقد اكتسب وتصوّر في القلب خرج في تلك
الحال عن أن يكون عملاً. ومن وجه آخر ضربان: واجب وندب فالواجب يقال له
العدل والندب يقال له الإحسان وهما المذكوران في قول الله تعالى: (إن الله
يأمر بالعدل والإحسان) فالفرض والعدل تحري الإنسان لما إذا عمله أثيب وإذا
تركه عوقب. والندب والإحسان تحري الإنسان لما إذا عمله أثيب وإذا تركه لم
يعاقب والإنصاف من العدل والتفضل من البر والإحسان، فالإنصاف هو مقابلة
الخير من الخير والشرّ من الشرّ بما يوازيه، والتفضل والبر هو مقابلة
الخير بأكثر منه والشر بأقل منه. فالإحسان والتفضل احتياط في العدالة،
والإنصاف ليؤمن به من وقوع خلل فيه وذلك إذا زدت في إعطاء ما عليك ونقصت
في أخذ ما لك فقد احتطت وأخذت بالحزم، كدفع زيادة زكاء إلى الفقير وترك ما
أُحل لك أن تتناول من مال اليتيم. فالعدالة إن كانت جميلة فالتفضل أحسن
منها. ولذلك قال تعالى فيمن استوفى حقه فتحرى العدالة: (وَلمَن انتصر بعد
ظلمه فأُولئك ما عليهم من سبيل) وقال سبحانه بعده: (وأن تعفوا أقرب
للتقوى). وقال عز وجل: (ولا تنسُوا الفضل بينكم). إشارة إلى أن الإحسان
حسن والتفضل أحسن وقال عز وجل: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) فالإنسان
إنما يكون محسناً متفضلاً بعد أن يكون عادلاً منصفاً. فأما من ترك ما
يلزمه ثم تحرى ما لا يلزمه فإنه لا يقال له متفضل ولا يجوز تعاطي التفضل
إلا لمن كان مستوفياً وموفياً لنفسه، فأما الحاكم المستوفي والموفي لغيره
فليس له إلا تحري العدالة والنَّصَفَةَ.
فصل
العلوم من حيث الكيفية ضربان تصور وتصديق فالتصور هو أن يعرف الإنسان معنى الشيء صحَّ عنده ذلك بدلالة أو لم يصح كمن عرف الصلاة وشرائطها وإن لم تثبت صحتها عنده بدلالة والتصديق هو أن يتصور الشيء ويثبت عنده بدلالة تقضي صحته.والتصديق على ثلاثة أضرب: أما بغلبة الظن وهو أن يكون عليه دلالة
وقد يعترضها شُبه توهنها وتبطلها، قال الله تعالى: (إذا مسَّهم طائف من
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون). وأما بعلم اليقين وهو أن يصير بحيث يعلم
ويعلم أنه يعلم ولا تعترضه شبه توهنه كالعلم مثلاً بأن ثلاثة وثلاثة ستةٌ
وأنه لا يصح أن تكون أكثر من ذلك أو أقل، قال الله تعالى: (إنما المؤمنون
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا). وأما بعين اليقين وهو أن يرى
بعقله الشيء ويعانيه ببصيرته في حال اليقظة والنوم، وقد نبه الله تعالى
على هذه الوجوه بقوله: (كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون
علم اليقين لترونّض الجحيم ثم لترونَّها عين اليقين). فأما التصورات
المجردة فالعامة الذين قال الله تعالى فيهم: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى
أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه). وأما غلبة الظن فللعامة الذين
مدحهم الله بقوله: (والذين يظنون أنهم ملاقو ربهم). وأما علم اليقين
فللخاصة. وأما عين اليقين ففي الدنيا للأنبياء ولبعض الصديقين. وإلى نحوه
أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " تنام عيني ولا ينام قلبي "
وبقوله: " إني أرى من خلفي كما أرى من قدامي " . قال أمير المؤمنين عليّ
عليه السلام: لو كشف الغطاءُ ما ازددت يقيناً. وقال بعض الحكماء: علم
اليقين يحصل للعقل بالفكر والذكر فإن العقل بفكره أي ببحثه يدرك المعارف
وبذكره يستحضرها إذا نسيها وغفل واشتغل عنها وبذهنه ينظر إليها دائماً كما
ننظر نحن إلى محسوس غير غائب عن أبصارنا بلا حاجة إلى بحث وطلب وتفكر
وتذكر، وكذلك قيل الإنسان يعقل فينظر إلى الحق بالفكر، والملائكة دائماً
ينظرون إليه بالذهن من غير حاجة إلى تفكر وطلب.
فصل
للإنسان في استفادة العلم وإفادته ثلاثة أحوال: حال استفادة فقط، وحال استفادة ممن فوقه وإفادة لمن دونه، وحال إفادة فقط، وقلَّ من يستحق أن يوجد مفيداً غير مستفيد، ففوق كل ذي علم عليم إلى أن ينتهي الأمر إلى علام الغيوب فقد نبه الله تعالى على الحاجة إلى الاستفادة بما حكاه من قول موسى عليه السلام لصاحبه: (هل اتبعك على أن تعلمني مما عُلّمت رشدا) ونبه بما ذكر في قصة سليمان عليه السلام عن الهدهد بقوله: (أحطتُ بما لم تحط به علماً). إن الكبير قد يفتقر إلى الصغير في بعض العلوم فإذاً الإنسان ما دام حياً يجب أن لا يخرج من كونه مستفيداً ومفيداً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الناس عالم ومتعلم وما سواهما همج " .الباب الرابع والعشرونفي أن الغرض من العبادة تطهير النفس واجتلاب صحتها
لم
يكلف الله الناس عبادته لينتفع هو تعالى بها انتفاع المولى باستعباد عبيده
واستخدام خدمه فإن الله غنيٌّ عن العالمين. ولا ليؤدبهم ليزيل أنجاسهم
وأمراضهم النفسية، فبذلك يمكنهم أن يحصلوا حياةً أبديةً باقيةً سرمديةً
فإن من وُلد يكون ميتاً بالإضافة إلى أصحاب الدار الآخرة وفاقداً للعين
التي بها يعرفهم والسمع الذي به يسمع تحاورهم واللسان الذي به يخاطبونه
ويخاطبهم والعقل الذي به يعقلهم، فليس تلكم الحياة والعين والسمع ما
للإنسان في الحياة الدنيا. وكيف يكون كذلك وقد نفى الله ذلك عن الكفار
وجعلهم أمواتاً وصُماًّ وبُكماًّ وعُمياًّ، فإن الإنسان له قوة على تحصيل
تلك الأمور في ابتداءِ أمره، وإن أهمل نفسه فأتت عنه تلك القوة فلا يمكنه
بعد قبول ذلك، كالفحم إذا صار رماداً فلا يقبل بعد ذلك ناراً، فمن استمرَّ
في كفره وفسقه وتمادى فيه صار أما ميتاً أو مريضاً أو أصمَّ لا يقبل
الشفاء، ولذلك قال الله تعالى فيمن ثكِل هذه القوة: (إنك لا تسمع الموتى
ولا تسمع الصمَّ الدعاءَ إذا ولَّوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن
ضلالتهم). وقال تعالى: (صمٌّ بكمٌّ عميٌّ فهم لا يعقلون) وقال تعالى: (في
قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت). وقال تعالى: (إنما
المشركون نَجَسٌ). وقال تعالى في المؤمنين: (لينذر من كان حياً). وقال
فيهم: (أولي الأيدي والأبصار). فمن استفاد الحياة والصحة والطهارة قبل أن
تبطل عنه هذه القوى أعني قبول ذلك فصار حياً سميعاً بصيراً طاهراً وحصل
زاداً كما أمره الله تعالى بقوله: (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله
الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور). وائتمر له
تعالى بقوله: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم). واقتدى بالموصوفين بقوله
سبحانه: (يسارعون في الخيرات). فجديرٌ أن يفلح فيحصل هذه السعادة كما قال
الله تعالى: (لعلكم تفلحون).
الباب الخامس والعشرون
في بيان الأمراض والأنجاس التي لا يمكن إزالتها إلا بالشرعكما
أن في بدن الإنسان عوارض وأموراً موجودة عند الولادة أو توجد حالاً فحالاً
بحكمة تقتضي ذلك وهي تعد نجاسات لا بد من إماطتها كلها أو إماطة فضولاتها،
وذلك كالسَّلى والسرَّة والقلفة والعقيقة الموجودة في الصبي عند الولادة
وكالأوساخ والقمل والظفر وشعر العانة وشعر الإبط، كذلك في نفس الإنسان
عوارض هي نجاسات وأمراض نفسانية يلزم إماطتها كالجهل والشره والعجلة والشح
والظلم. ويدل على كون ذلك مخلوقاً فيه وأمره بإماطته وإماطة فضلاته ما ذكر
الله تعالى في مواضع من كتابه بقوله: (خُلق الإنسان من عجل) فذكر أنه
مخلوق منه كما ترى. ثم أمره أن ينحيه عن نفسه وأن لا يستعين به فقال:
(سأُريكم آياتي فلا تستعجلون). وقوله تعالى: (إنه كان ظلوماً جهولا). ثم
أمره بالعلم والعدل في غير موضع من كتابه. وقوله تعالى: (وأحضرت الأنفس
الشحَّ). ثم قال: (وَمَنْ يوق شحَّ نفسه فاولئك هم المفلحون). فأمر باتقاء
الشح مع إحضاره إياه. وقوله تعالى: (إن الإنسان خُلق هلوعا إذا مسه الشرُّ
جزوعا وإذا مسه الخير منوعا). ووصفه بالكفور والقتور في قوله: (وكان
الإنسان كفورا). وقوله تعالى: (قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً
لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا). فأدخل عليه " كان " تنبيهاً
على أن ذلك فيه غريزي موجود قبل لا هو شيءٌ طارئٌ عليه. وقوله تعالى:
(وكان الإنسان أكثر شيءٍ جدلاً). ثم نهى عن أكثر الجدال فالإنسان يحتاج أن
يستعمل هذه القوى في الدنيا كما يجب وفي وقت ما يجب وأن يميط فضولاتها قبل
خروجه من الدنيا حسب ما وردت به الشريعة، فإنه متى لم يتطهر من النجاسة،
ولم يُزل أمراض نفسه لم يجد سبيلاً إلى نعيم الآخرة، بل ولا إلى طيب
الحياة الدنيا، وذلك من تطهر تجلى عن قلبه الغشاوة فيعلم الحق حقاً
والباطل باطلاً فلا يشغله إلا ما يعنيه، ولا يتناول إلا ما يعنيه فيحيا
حياة طيبة كما قال تعالى: (فلنحيينَّه حياة طيبة) ولا تصير قنياته في
الدنيا وبالاً عليه وعذاباً كما قال الله تعالى في الكفار: (فلا تعجبك
أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق
أنفسهم وهم كافرون). ويصير قلبه إذا تطهر مقرَّ السكينة والأرواح الطيبة
كما وصف الله تعالى المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم). وعرف الطريق
التي بها التوصل إلى الحنة المأوى ومصاحبة الملأ الأعلى في مقعد صدق عند
مليك مقتدر، فيسارع في الخيرات ويسابق إلى مغفرة من ربه. ومتى بقيت نجاسته
وتزايدت صار قلبه مقرَّ الشبه والآثام كما قال الله تعالى: (هل أنبئكم على
من تَنَزَّلُ الشياطين تنزل على كل أفَّك أثيم). ولا يجد سبيلاً إلى سعادة
الدار الآخرة كما قال الله تعالى: (أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم
كلاّ إنا خلقناهم مما يعلمون) فنبه على أنه لا يصلح لجنته ما لم تطهر ذاته
عن أشياء هي مخلوقة فيها وعلى هذا دلَّ قوله تعالى: (ما كان الله ليذر
المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب). فحق الإنسان أن
يراعي هذه القوى فيصلحها ويستعملها على الوجه الذي يجب وكما يجب ليكون كمن
وصفه الله تعالى بقوله: (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلامٌ عليكم
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون). وقد يقع للإنسان شبهة في أمر هذه النجاسات
فيقو: أترى أن ذلك من عند غير الله؟ فإن كان من غيره فمن أين يوجده؟ ومن
أين منبعه؟ وإن كان منه فما المعنى في أن أوجده في الإنسان ثم أمره بأن
يزيله؟ فيقال لم يعرف ذلك البشر، لكن من الأشياء ما نفعه في وقت مخصوص أو
إذا كان على قدر مخصوص، ثم إذا استغني عنه أو زاد على قدر ما يحتاج إليه
يجب أن يزال وذلك إذ تؤمل ظاهر إذ من المعلوم أن السلا والسرة يحتاج
إليهما لصيانة الولد في وقت ثم يستغني عنهما، فيكون إبقاءهما بعد نجاسة
والشعر والظفر يحتاج إليهما إذا كان على حد وإذا زادا يجب إماطتهما.
الباب السادس والعشرون
في القوى التي يجب إزالة أمراضها وأنجاسها والمعاني التي تحصل منهاإزالة
الأنجاس واجتلاب الطهارة المذكورة في قوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) واكتساب الصحة وإماطة المرض المذكور
في قوله تعالى: (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً) يكون بإصلاح القوى
الثلاث التي هي دواعي الإنسان في متصرفاته وهي قوة الشهوة وقوة الحمية
وقوة الفكر فبإصلاح قوة الشهوة تحصل العفة فيتحرز بها من الشره وإماتة
الشهوة ويتحرى المصلحة في المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح وطلب الراحة
وغير ذلك من اللذات الحسية، وبإصلاح قوة الحمية تحصل الشجاعة فيتحرز من
الجبن والتهور والحسد ويتحري الاقتصاد في الخوف والغضب والأنفة وغير ذلك.
وبإصلاح قوة الفكر تحصل الحكمة حتى يحترز من البله والجربزة ويتحرى
الاقتصاد في تدبير الأمور الدنيوية. وليس نعني بالحكمة ههنا العلوم
النظرية وإنما نعني بها الحكمة العملية التي يتحري بها المصالح الدنيوية،
وبإصلاح هذه القوى يحصل في الإنسان قوة العدالة فيقتدي بالله تعالى في
سياسة نفسه وسياسة غيره، فنفس الإنسان معادية له كما قال تعالى: (إن النفس
لأمارة بالسوءِ إلا ما رحم ربي) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعدى
عدوك نفسك التي بين جنبيك " فمن أدبَّها أو قمعها أو من ظلمها وإلى هذا
أشار الله تعالى بقوله: (ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا
هضما) أي لا يخاف أن تظلمه نفسه الشهوية فالأعمال الصالحة حصن منها لقول
الله تعالى: (إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر).
الباب السابع والعشرون
في كون الإنسان مفطور على إصلاح النفس الإنسان مفطور في أصل الخلقة على أن يصلح أفعاله وأخلاقه وتمييزه وعلى أن يفسدها وميسَّر له أن يسلك طريق الخير والشر وإن كان منهم من هو بالجملة إلى أحدهما أميل. وعلى تمكنه من السبيلين دلَّ الله بقوله: (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا) وقوله تعالى: (وهديناه النجدين) أي عرَّفناه الطريقين، وكما أنه مفطور على اكتساب الأمرين في ابتدائه مفطور على أنه إذا تعاطى أحدهما أن خيراً وأن شراًّ ألفه، فإذا ألفه تعوَّده، وإذا تعوده تطبع به، وإذا تطبع به صار له طبعاً وملكة فيصير فيه بحيث لو أراد أن يتركه لم يمكنه كما قيل: " وتأبى الطباع على الناقل " ويكون مثله كمثل شجر نبت فاعوجَّ سهل في الابتداء تثقيفه وتسويته بخيط يشد أو بخشب يفرش بجنبه فيسدد به. ثم إذا غلظ واشتد مستوياً أمن أن يعوج بل لا يمكن تعويجه، وإن ترك حتى يعوجَّ فيصلب على عوجه لم يمكن تثقيفه كما قال الشاعر:يقوَّم بالثقاف العود لدْناً ... ولا يتقوَّم العودُ الصليبُ
على هذا الوجه قال الله تعالى: (إن الحسنات يذهبن السيئات) وقال تعالى: (ويدرأون بالحسنة السيئة) وقد توهم قوم أن لا أثر للتأديب والتهذيب فإن الناس مجبولون على طبائع لا سبيل إلى تغييرها، فمنهم أخيار بالطبع، ومنهم أشرار بالطبع واستدلوا بقول الله تعالى: (قل كلٌّ يعمل على شاكلته) وقوله تعالى: (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) فنبه الله بهذا المعنى على إن كل إنسان على حال لا سبيل إلى تغييرها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلٌّ ميسر لما خلق له " . وقوله عليه السلام: " فرغ ربكم من الخَلْقِ واَلْخلُقِ والرزق والأجل " . وبقوله تعالى: (ولقد اصطفيناه في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين) وقوله: (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) وقوله: (ولقد اخترناهم على علم على العالمين) والناس وإن تفاوتوا في أصل الخلقة فما أحد إلا وله قوة على اكتساب قدر ما من الفضيلة ولولا ذلك لبطلت فائدة الوعظ والإنذار والتأديب.
الباب الثامن والعشرونفي سبب رذيلة الإنسان وتأخره عن الفضيلة
سبب
تأخر الإنسان عن الفضيلة لا تخلو من أوجه: إما أن تكون نقصاً في أصل خلقته
وعجزاً مركباً في جبلته يتقاعد به عن تحصيل القوة وجمع الآلة التي يتوصل
بها إلى السعادة كمن تضعف نحيزته، أو لا يفضل عن طلب معايشه الضرورية في
وقته، أو لا يجد هادياً يرشده، فمن كان كذلك فمعذور لقوله تعالى: (لا يكلف
الله نفساً إلا وسعها) وأما أنه غير عاجز عن ذلك لكن لم يساعده على بلوغه
عمره فذلك قد وقع أجره على الله لما قال الله تعالى: (ومن يخرج من بيته
مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله). وأما أن
يتفق له مُرَبٍ ومعلم مُضلٌ فيضله عن الطريق، وهذا إن لم يتمكن من
الاهتداء بمن يرشده ويسدده يكون معذوراً، والإثم فيما يرتكبه لمن قد أضله
لا له كما قال الله تعالى في المضلين: (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألاَ ساءَ ما يزرون). وإن تمكن بعد ممن
يهديه فلم يهتد به يكون هو ومضله مشتركين في الإثم كما قال الله تعالى:
(احشروا الذين ظلموا وأزواجهم). وأما أن يكون ضلاله من جهة نفسه لا من جهة
شيء مما تقدم، وذلك هو المتوعَّد بالعذاب، فمن أزاح الله علته بالفهم
والكفاية والعلم الناصح فرغب عن الاهتداء وترك طريقة الرشاد، يكون كمن
وصفه الله تعالى بقوله: (واتلُ عليهم نبأَ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها
فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين) وبقوله: (ولقد أريناه آياتنا كلها فكذَّب
وأبى) وأكثر منه عقوبة من استفاد العام وعرف الحق وسلك من طريق الخير
مراحل ثم ارتد عنها راجعاً، كمن وصفه الله بقوله: (إن الذين ارتدوا على
أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى سوَّلَ لهم وأملى لهم) وبقوله: (ومن
يرتد منكم عن دينه... الآية).
الباب التاسع والعشرون
في أحوال الناس ومنازلهم وفي تعاطي الأفعال المحمودة والمذمومة وطرقها الناس في إقامة العبادات وتحري الخيرات على أربعة أضرب: الأول من له العلم بما يجب أن يفعل وله مع ذلك قوة العزيمة على العمل به وهم الموصوفون بقوله عزَّ وجل في غير موضع: (الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب). والثاني من عدمهما جميعاً وهم الموصوفون بقول الله تعالى: (إن شرَّ الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) وقوله: (إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا). الثالث. من له العلم وليس له قوة العزيمة على فعله، فهو في مرتبة الجاهل بل هو شرٌّ منه، كما روي أن حكيماً سئل: متى يكون العلم شرّاً من الجهل فقال: أن لا يعمل به. وروي عن أمير المؤمنين عليّ كرَّم الله وجهه أنه قال: من كانت ضلالته بعد التصديق بالحق فهو بعيد من المغفرة. الرابع من ليس له العلم لكن له قوة العزيمة، فهذا متى انقاد لأهل العلم وعمل بقولهم أنجح في فعله وصار من الموصوفين بقوله تعالى: (أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً).والأفعال الجميلة والقبيحة يتقوى الإنسان فيها بتكريرها مراراً كثيرة وزماناً طويلاً وقتاً بعد وقت في أوقات متفاوتة، فإن من فعل ذلك في شيءٍ اعتاده، وإذا اعتاده تخلق به، فالحذق في الصناعة كالكتابة مثلاً يكون باعتياده فعل من هو حاذق في الكتابة. والأفعال التي يتعاطاها المتخلق بها تصير خلقاً. فحق الإنسان أن يتدرب بفعل الخير، فإن من تعوَّد فعلاً صار له ملكة، كالصبي قد يلعب بتعاطي صناعة فيؤدي لعبه بها إلى أن يتعلمها.
فصل
العبادات
تكون محمودة إذا تعاطاها الإنسان طوعاً واختياراً لا اتفاقاً واضطراراً
ودائماً في زمان دون زمان، لأجل أن ذاتها حسنة لا لأجل غيرها، فمن أقامها
على هذا الوجه فهو الموصوف بقوله تعالى: (واخلصوا دينهم لله فأولئك مع
المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً). وقال النبي صلى الله
عليه وسلم: " أخلص يكفك القليل من العمل ولا يرضى تعالى إلا الإخلاص " كما
قال الله تعالى: (ألاَ لله الدين الخالص). فإن من فعل خيراً نحو أن يصلي
لأنه اتفق اجتماعه مع المصلين فساعدهم أو أكره أن يصلي أو صلاَّها في شهر
رمضان مثلاً دون سائر الأوقات أو لأجل أن ينال بها جاهاً أو مالاً، فليس
ذلك مما يستحق بها محمدة. وكذا من ترك قبيحاً أما اتفاقاً أو اضطراراً أو
خوفاً أو في أي زمان دون زمان أو لأن ينال بذلك أمراً دنيوياً فليس
بمحمود، ولهذا قال الله تعالى: (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا
يتبعون ما أنفقوه مَنّاً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا
هم يحزنون). تنبيهاً على أن من لم يُنفق ماله هكذا ويعلوه خوفٌ من الفقر
وحزن على الإنفاق فلا يحصل له بذلك فضيلة ثم قال تعالى: (يا أيها الذين
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي ينفق ماله رئاءَ الناس ولا
يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب... الآية).
الباب الثلاثون
في ارتداد الناس من طريق الخير والشر للإنسان فيما يتحراه من الخير والشر حالتان: حالة يتمكن فيها من الارتداد على ادباره فيما يتعاطاه ان خيراً وان شراً وذلك قبل ان يمعن في سيره ويتناهى في ممره. وحالة يتعذر عليه الارتداد على ادباره بل لا يكون له سبيل الى الرجوع وذلك اذا امعن في سيره وتناهى في ممره. وذلك ان كل من كان متعاطياً لفعل خير فتكاسل عنه، ومتعاطياً لشرٍّ فلم يقلع عنه، اورثه كسله ضيق صدر بتحري الخير كما قال الله تعالى: (ومن يُرد ان يُضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً). وانشراح صدره بفعل الشر كما قال تعالى (فمن زُين له سوءُ عمله فرآه حسناً). فإن استمر على ذلك ولم يقلع، اورثه ذلك رَيْنا على قلبه كما قال الله تعالى: (كلاَّ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون). فإن تمادى في ذلك واستمر اورثه ذلك غشاوة، كما قال تعالى: (فاغشيناهم فهم لا يبصرون) فإن ازداد اورثه ذلك طبعاً وختماً، كما قال تعالى: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم). وقوله: (أَفرأيت من اتخذ آلهه هواه واضله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون). فإن ازداد صار ذلك قُفلاً كما قال الله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها). ثم إذا تمادى صار قلبه موتاً قلما ترجى له حياة فلا تنفعه الآيات والنذر كما قال الله تعالى: (إنك لا تُسمع الموتى ولا تسمع لصم الدعاء إذا ما ينذرون). ومن حيث أن الله تعالى علم من أحوال من بلغ هذا المبلغ أنه لا يتوب ولا يؤوب قال الله تعالى: (الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون). فلم يرد تعالى أنهم إذا تابوا لم تقبل توبتهم بل نبه بذلك على أنهم لا يتوبون فتقبل توبتهم فدل منتهى الفعل على مبدأه وهذا من كلامهم كقول الشاعر: " ولا يرى الضبُّ بها ينجحر "ي ليس بها ضب فينجحر فنفي انجحار الضب وهو في الحقيقة نفي لوجود
الضب بها، وعلى هذا دل قوله تعالى: (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم
كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا). أي لم
يكونوا ليتوبوا فيغفر لهم، وعلى هذا قال تعالى: (إنما التوبة على الله
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب). تنبيهاً على أن هؤلاء هم
الذين يرجى لهم التوبة. وعلى هذه الجملة المذكورة قال النبي صلى الله عليه
وسلم: " إذا أذنب الرجل نكُتت على قلبه نكتة سوداء فإذا أذنب ثانياً نكتت
أخرى فلا يزال كذلك حتى يصير قلبه كلون الشاة الرمداء " . وفي خبر آخر: "
الذنب على الذنب حتى يسود القلب فلا تُرجى له الإنابة " . وكذا حال
الإنسان فيما يتعاطاه من فعل الخير فإن من صبر في اقتراف الحسنة أورثه
صبره حسناً كما وصف الله به الصابرين في مواضع من كتابه قال تعالى: (ومن
يقترف حسنة نزد له فيه حسناً). فإن استمر في ذلك بعض الاستمرار اهتز ونشط
وانشرح به صدره كما قال تعالى: (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره
للإسلام). فإن دام على ذلك امتحن وتطهر قلبه كما قال الله تعالى: (أولئك
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى). ويكون كما وصفه في هذه السورة: (ولكن
الله حبَّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق
والعصيان أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم). فإن
تزايد في فعله إنضم إليه من الله تعالى باعثٌ يهزه وداع يبعثه عليه كما
قال الله تعالى: (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً
مع إيمانهم). فحق الإنسان أن لا يسامح نفسه في الاجتهاد وأن لا يخلّ بخير
تعوّده ولا يرخص لها في شر ارتكبه، فتعاطي صغير الذنب يفضي إلى ارتكاب
الكبير، والإخلال بقليل الخير يؤدي إلأى الإخلال بكثير كما قال الشاعر:
وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه ... وأول الغيث قطر ثم ينسكب
وقد
نبه الله تعالى على ذلك بقوله: (إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما
تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما
نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر). فتبين أن قولهم للذين كرهوا ما نزل الله
أدى بهم إلى الارتداد على أدبارهم وقال تعالى: (إن الذين تولوا منكم يوم
التقى الجمعان إنما استنزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا). فنبه على أن بعض ما
كسبوا أدى بهم إلى الانهزام، فالمتدرب في فعل الخير المتقوي فيه يصير بحيث
يكون له من الله تعالى واقية تحفظه عن الأفعال القبيحة وتحثه على الأفعال
الحسنة. وهذا معنى العصمة وعلى ذلك نبه الله تعالى في صفة أولياءه بقوله:
(أولئك كُتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحٍ منه). وقال تعالى: (رضي الله
عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا أن حزب الله هم المفلحون). والمتدرب
بفعل الشر المتقوي فيه قد يصير بحيث يكون له بما ارتكبه من القبائح باعث
يبعثه على الأفعال القبيحة ويحثه على الأفعال السيئة ويسد عليه طرق
الأفعال الحسنة، وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله في صفة أعدائه: (إنا جعلنا
في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سداً
ومن خلفهم سدّاً فأغشيناهم فهم لا يبصرون). وقال تعالى: (ومن يعيشُ عن ذكر
الرحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين وأنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم
مهتدون). وقال تعالى: (إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون). وقد
نسب الله هداية العبد وضلاله جميعاً إلأى نفسه من حيث أنه جعل خلقه وطبعه
بحيث إذا تعاطى فعلاً إن خيراً وإن شراً فاستمر عليه يصير ذلك طبعاً له
ملازماً لا يرجع عنه، ولم ينسب المنع من الإيمان إلى نفسه إلا بعد ذكر ما
كان من إساءة العبد نحو قوله: (إنا جعلنا الشيطاين أولياء للذين لا
يؤمنون). فخص الذين لا يؤمنون بأن جعل الشيطان أولياءهم وقال تعالى: (ومن
الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من
تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير). وقال تعالى: (إن الذين لا يؤمنو
بالآخرة زيّنا لهم أعمالهم فهم يعمهون). قال الشاعر:
زُين في عينك القبيح كما ... زُين في عين غيرك الحسنُ
الباب الحادي والثلاثون
في قدر ما في الوسع من اكتساب السعادةالإنسان لما كان على هيئة العالم أوجد فيه كلُّ ما أوجد في العالم، وكما أن في العالم أشياء لا يتأتى إصلاحها وحيوانات لا يمكن تأديبها كذلك في الإنسان قوى لا يتآتى إصلاحها وتهذيبها وكان له مع ذلك مثبطات عما أمر به وتقصير عما كُلف ولهذا قال الله تعالى: (قُتل الإنسان ما أكفره من أي شيءٍ خَلَقَه). إلى قوله: (كلا لم يقض ما أمره). فنبه على أن الإنسان لا يكاد يخرج من دنياه وقد قضى وطره، ولذلك يجب على الإنسان أن يجتهد في أداء ما أمكنه، ويطهر نفسه بقدر ما يتيسر له والرغبة إلى الله تعالى في تكفير ما قصر فيه ويتحقق أنه إذا فعل ما أمكنه فقد أعذر لقوله تعالى: (لا يكلف نفساً إلا وسعها). فإذا فعل ما أمكنه يكون قد ترشح أن يزيل الله عنه باقي السيئات كما قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم). وقال تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريما). ولهذا أمرنا تعالى أن ندين الدعاء بقوله: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنا). وقال تعالى: (والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا). فأمرنا أن نرغب إليه في إتمام ما قصرنا عن اكتسابه وقوله: (والذي جاء بالصدق إلى قوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون). ولهذه الجملة قال جعفر الصادق رضي الله عنه: من زعم أنه يصل إلى الحق ببذل المجهود فهو متعنٍ ومن زعم أنه يصل إليه بغير بذل المجهود فهو متمنّ ولقصور الإنسان عن تزكية نفسه بالتمم قال صلى الله عليه وسلم: " ما أحدٌ يدخل الجنة بعمله " قيل ولا أنت يا نبي الله قال: " ولا أنا إلاّ أن يتغمدني الله برحمته " . وقال تعالى تنبيهاً على هذا المعنى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء). وبيان قصور الإنسان عن تزكية نفسه على التمام هو أن الإنسان حيوان ناطق متفكر والحيوان جوهر متنفس حساس، والمتنفس جوهر متغذ مترب لا قوام له إلا بالغذاء كما قال الله تعالى: (وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين) فالإنسان ما دام في الدنيا لا ينفك عن مشاركة البهائم والسباع لكونه حيواناً محتجاً إلى ما تحتاج إليه وعن مشاركة الحيوان والنبات لكونه متنفساً محتاجاً غلأى ما تحتاج إليه. والإنسان إذا لم يقتحم العقبو ويفك الرقبة وما لم يتعر عن الحاجات لدنية لم يأمن شياطين الإنس والجن فكيف يأمن وقد قال الله تعالى: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا). قال بعض المفسرين: إن إبراهيم لما سأل الله تعالى فقال: (ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي). إنما سأله أن يريه الحياة المتعرية عن العوارض العارضة للحيوانات فقال: أو لم تؤمن أي أو لم تتحقق؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي أي ليتصور لي كيفية الطمأنينة أي تبري النفس من الشره والحرس والأمل والإفتخار وأعاين الحالة المذكورة في قوله تعالى: (يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي). فأمره أن يأخذ أربعة طيور. غراباً وهو المخصوص بالحرص والشره. ونسراً وهو المخصوص بالأمل وطاووساً وهو المخصوص بالإفتخار. وديكاً بالشبق، فأَمره أَن يقطّعهن ويصرهنَّ أي يدعوهن، ولما فعل ذلك صِرن إليه عاجلاً فنبه الله تعالى بذلك على أن الإنسان وإن اجتهد كلَّ الاجتهاد في حذف هذه المعاني عن نفسه وتطهير ذاته منها لن يتطهر ما دامت البشرية الدنيوية حاصلة له ولن تحصل له الطمأنينة المطلوبة. فأَما ما يدعيه قوم أن من الناس من قد تجرد عن هذه الخصائص حتى يستغني عن الطعام والشراب ويصير بحيث لا تعتريه الأخلاق البهيمية فهذا إن حصل في بعض الناس فإذ ذلك يكون ملكاً متشبحاً يسمى بإسم الإنسان على سبيل الإشتراك في الإسم، فيكون متبدل الجوهر تبدل جوهر النار إذا صارت برداً وسلاماً، وتبدل الدُعموص إذا صار ضفدعاً، والدود إذا صار فراشاً، وكثيراً من النبات إذا صار جوهراً آخر، وجيواناً كدودة القز وليس ذلك بمنكر في القدرة الإلهية وهو حينئذ خارج عن الاستصلاح للأفعال التي خلق الإنسان لأجلها مستخلفاً في الأرض مستعمراً فيها.
فصل
اعلم من هاجر إلى الله وجاهد في سبيله فحقيق أن يهديه إلى سبيله كما وعد في قوله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهديّنهم سبلنا). وقال: (والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا... إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقاً). والهجرة العظمى هجران فضول الشهوات والمجاهدة الكبرى مدافعة الهوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " جهادك في هواك " . فمن هدي إلى سبيله وأمعن في مسيره مسارعاً في الخيرات ومسابقاً إلى مغفرة ربه فحقيق أن يصير من الإبدال، ومعنى الإبدال هم الذين يبّدلون من أخلاقهم وأفعالهم الذميمة أخلاقاً وأفعالاً حميدة، فيجعلون بدل الجهل العلم وبدل الشح الجود وبدل الشره العفة وبدل الظلم العدالة وبدل الطيش التؤَدة وعلى ذلك دل قوله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله: يبدّل الله سيئاتهم حسنات). والإنسان إذا صار من الإبدال فقد ارتقى إلى درجة الأحباب الذين عناهم الله تعالى بقوله: (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم). فجعله مهيباً في البشر، معظم القدر عند كل واحد، بل قد يبلغ مبلغاً تخضع له البهائم والسباع والوحوش والحشرات كخضوعها لسليمان بن داود عليهما السشلام، ويصير الحديد له ليِّناً كما لان لنبيه داود عليه السلام، وتصير النار له إذا خاضها برداً وسلاماً كما صارت على إبراهيم عليه السلام وتنقاد له الريح فيركبها كركوب سليمان، وتسخر له المياه فيمشي عليها كتسخيرها للخضر عليه السلام، ويكلمه النبات والمعادن والأفلاك والنجوم فتفقه على منافعها وتخبره بسرائرها كمكالمتها لإدريس عليه السلام. روي أنه إذا أحب الله عبداً ألبسه صورة من صورته، ونفخ فيه روحاً من روحه، حتى ينقاد له كل حجر ومدر، ويتواضع له كل طائر وسبع، بل قد يخصه بكرامات لا يمكن أن يطلع على معرفتها غيرُ من خُصَّ بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: " أعددتُ لعبادي الصلحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر " وقال تعالى إشارة لها هذا المعنى. (فلا تعلم نفس ما أُخفي لهم من قرة أعين) وهذه الأحوال كما تكون للأنبيء فقد تكون للأولياء المخصوصين بالكرامة وليس ذلك بمستبدع ولا منكر في قدرة الله تعالى ولا بمناف في حكمته كما ظن بعض المتكلمين أن ذلك إذا أظهره على ير أنبياءه لا يُؤمَنُ أن يُفتن به الناسُ وإنه يؤدي إلى اشتباه أمر لمعجزة على الكافة، فإن أحكم الحاكمين لا يؤتى هذه المكرمة إلا من هو أهلها كما نبه عليه سبحانه بقوله: (ألله أعلم حيث يجعل رسالته) ومن بلغه هذه المنزلة فقد آتاه لا شك من العلم والحكمة قدر ما يهديه ويؤدبه، وعرف ما يمسكه فيستقيم كما أمر فيه فيعرف قدره ولا يتعدى طوره.الباب الثاني والثلاثونفي إثبات المعاد وفضيلة الموت وما يحصل بعده من السعادة
لم
ينكر المعاد والنشأة الآخرة إلا جماعة من الطبيعيين أهملوا افكارهم وجهلوا
أقدارهم، وشغلهم عن التفكير في مبدأهم ومنشأهم شغفُهم بما زين لهم من حب
الشهوات المذكورة في قوله تعالى: (زُين للناس حب الشهوات من النساء
والبنين والقناطير لمقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا). وأما من كان سوياً ولم يمش مكباً على
وجهه لكونه: (كالأنعام بل هم أضل سبيلا) وتأمل أجزاء العالم علمٌ أن
أفضلها ذوات الأرواح وأفضل ذوات الأرواح ذوو الإرادة والاختيار في هذا
اعالم، وأفضل ذوي الإرادة والاختيار الناظر في العواقب وهو الإنسان فيعلم
أن النظر في العواقب من خاصية الإنسان، وأنه لم يجعل تعالى هذه الخاصية له
إلا لأمر جعله له في العقبى، وإلا كان وجود هذه القوة فيه باطلاً فلو لم
يكن للإنسان عاقبة ينتهي إليها غير هذه الحياة الخسيسة المملوءة نصباً
وهماً وحزناً ولا يكون بعده حالٌ مغبوطة لكان أخس البهائم أحسن حالاً من
الإنسان، فيقتضي أن تكون هذه الحكم الإلهية والبدائع الربانية التي أظهرها
الله تعالى في الإنسان عبثاً كما نبه الله تعالى عليه بقوله تعالى:
(أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) فإن أحكام بنية
الإنسان مع كثرة بدائعها وعجائبها ثم نقضها وهدمها من غير معنى سوى ما
تشاركه فيه البهائم من الأكل والشرب والسفاد مع ما يشوبه من التعب الذي قد
أغني عنه الحيوانات سفهٌ: (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا) تعالى
الله عن ذلك علواً كبيرا. وما أظهر عند من ألقى عن مناكبه دثار العماية
صدق أمير المؤمنين عليّ عليه السلام في قوله: الدنيا دار ممر لا دار مقر
فاعبروها ولا تعمروها وقد خُلقتم للأبد ولكنكم تنقلون من دار إلى دار حتى
يستقر بكم القرار. وكثير من الجهال اتروا بقوم وصفوا بوفور العقل في أمور
الدنيا حيث أنكروا أمر الآخرة فقالوا: لو كان ذلك حقاً لم ينكره أمثالهم
مع وفور عقولهم وكثرة فهمهم ولم يعلموا أن العقل وإن كان جوهراً شريفاً
فإنه لا يتوجه إلا حيث وجه ولا غناء له إلا فيما إليه صُرف فإذا صُرف، إلى
أمور لآخرة أحكمها وإذا صرف إلى أمور الدنيا قبلها وعكف عليها، وأخل بما
سواها فتقصر بصيرته حينئذ عن الأمور الأخروية كما نبه الله عليه في غير
موضع من كتابه وقد تقدم القول فيه.
؟
فصل
اعلم أن الموت المتعارف الذي هو مفارقة الروح للبدن هو أحد الأسباب الموصلة للإنسان إلى النعيم الأبدي، وهو انتقال من دار إلى دار كما روي: " إنكم خلقتم للأبد لكنكم تنقلون من دار إلى دار حتى يستقر بكم القرار. فهو وإن كان في الظاهر فناءً واضمحلالاً فهو في الحقيقة ولادة ثانية قال الشاعر في ذلك:تمخضت المنون له بيوم ... أتى ولكل حاملة تمام
فإنه جعل للمنون حملاً كحمل المرأة وتمخضاً متمخضها وولادة وولادة كولادتها تنبيهاً على انه أحد أسباب الكون. قال بعضهم: الإنسان ما دام في دنياه جار مجرى الفرخ في البيضة فكما أن من كمال الفرخ تفلق البيض عنه وخروجه منه، كذلك من شرط كمال الإنسان مفارقة هيكله ولولا هذا الموت لم يكمل الإنسان، فالموت إذن ضروري في كمال الإنسان، ولكون الموت سبباً للإنتقال من حال أوضع إلى حال أشرف وأرفع سماه الله تعلى توفياً وإمساكاً عنده فقال تعالى: (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) ولهذا تقول العرب: استأثر الله بفلان، ولحق بالله ونحو ذلك من الألفاظ ولأجل أن الموت الحيواني انتقال من منزل أدنى إلى منزل أعلى أحبه من وثق بما له عند الله، ولم يكره هذا إلا أحد رجلين أحدهما من لا يؤمن بالآخرة وعنده أن لا حياة ولا نعيم إلا في الدنيا كمن وصفهم الله تعالى بقوله: (ولتجدنهم أحرص لناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يُعمَّر). وقال بعض من هذه طريقته شعراً في هذا المعنى:
خذ من الدنيا بحظ ... قبل أن تنقل عنها
فهي دار ليس تلقى ... بعدها أطيب منها
والثاني
يؤمن به ولكن يخاف ذنبه، فأما من لم يكن كذلك فإنه يحبه ويتمناه كما أحبه
الصالحون وتمنوه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أحب
لقاء الله أحب الله لقاءه " وقال تعالى: (فتمنوا الموت إن كنتم صادقين)
تنبيهاً على أن من يكون متحققاً بحسن حاله عند الله لم يكره الموت. فالموت
هو باب من أبواب الجنة منه يتوصل إليها، ولو لم يكن موت لم تكن الجنة
ولذلك منَّ الله تعالى به على الإنسان فقال: (الذي خلق الموت والحياة
ليبلوكم أيكم أحسن عملا) فقدم الموت على الحياة تنبيهاً على أنه يتوصل به
إلى الحياة الحقيقية وعدّه علينا في نعمه فقال: (كيف تكفرون بالله وكنتم
أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم) فجعل الموت أنعاماً كما جعل الحياة
أنعامأ لأنه لما كنت الحياة الأخروية نعمة لا وصول إليها إلا بالموت
فالموت نعمة لأن السبب الذي يتوصل به إلى النعمة نعمة، ولكون الموت ذريعة
إلى السعادة الكبرى لم يكن الأنبياء والحكماء يخافونه، حتى قال أمير
المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام: والله ما أبالي أقع على الموت أو
يقع الموت عليَّ. وكانوا يتوقعونه ويرون أنهم في حبس فينتظرون المبشر
بإطلاقهم. وعلى هذا روي: " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر " . وقيل أنه
لما مات داود الطائي سمع هاتف يقول: " أطلق داود من السجن " . قال الله
تعالى: (ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون) تنبيهاً على أن الموت سبيل
الحياة المستفادة عند الله تعالى. وقال تعالى: (ولئن قتلتم في سبيل الله
أو متم لمغفرةً من الله ورحمة خيرٌ مما يجمعون) وقال تعالى: (ولا تحسبن
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتأً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون
فرحين...الآية) وعلى هذا نبه الله تعلى بقوله: (ثم أنشأناه خلقاً آخر
فتبارك الله أحسن الخالقين ثم أنكم بعد ذلك لميتون ثم أنكم يوم القيامة
تبعثون) فنبه على أن هذه التغييرات خلق أحسن فنقض هذه البنية لإعادتها على
وجه أشرف كالنوى المزروع الذي لا يصير نخلاً مثمراً إلا بعد إفساد جثتها،
وكذلك البر إذا أردنا أن نجعله زيادة في أجسامنا يحتاج أن يطحن ويعجن
ويخبز ويأكل فيغير تغيرات كثيرة هي فساد لها في الظاهر، وكذلك البذر إذا
ألقي في الأرض يعده من لا يتصور مآله وحاله فساداً، فالنفس تحب البقاء في
هذه الدار إذا كانت قذرة راضية بالأعراض الدنيوية رضا الجُعَل بالحُش أو
جاهله بمآلها في المآل .
الباب الثالث والثلاثون
في فضيلة الإنسان إذا شرف على الملائكة قد تقدم أن الناس ضربان: ضرب لم يحظ من الإنسانية إلا بالصورة التخطيطية من انتصاب القامة وعرض الظفر والقوة على الضحك ولغو من النطق يجري مجرى المكاء والتصدية وهو دون البهائم. وضرب هو الإنسان وهو المعنَّى بما خلق لأجله فمن كان كذلك فله حالتان: إحداهما حالته وهو في الدنيا ولم يقتحم العقبة ويفك الرقبة بل هو صريع جوعه وأسير شبعة، تنتنه العرقة وتؤلمه البقة وتقتله الشرقة، ولما يقض ما أمره، فهو ما دام في دنياه لا يحكم له [انه أفضل من الملائكة على الإطلاق. والحالة الثانية قد اقتحم العقبة وفك الرقبة بعدما قضى ما أمره، فصار من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل قد جعل في مقعد صدق عند مليك مقتدر ذا حياة بلا ممات وغنى بلا فقر وعز بلا ذل وعلم بلا جهل وقد قامت الملائكة تخدمه كما قال تعالى: (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) فحينئذ من جعل له هذه المنزلة فهو أفضل من كثير من الملائكة، أعاننا الله على بلوغ هذه المنزلة وجعلنا من المترشحين لها برحمته أنه على ما يشاءُ قدير.فهذا آخر ما قصدت من بيان تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين نفعني الله به ومن نظر فيه برحمته أنه على ما يشاء قدير ولحمد لله وصلواته على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.