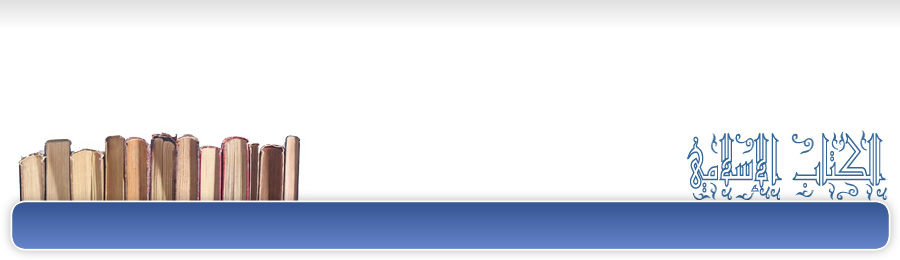كتاب : نهاية الإقدام في علم الكلام
المؤلف : الشهرستاني
القاعدة الأولى
في حدث العالم وبيان استحالة حوادث لا أول لها واستحالة وجود أجسام لا
تتناهى مكاناًمذهب أهل الحق من أهل الملل كلها أن العالم محدث ومخلوق أحدثه الباري تعالى وأبدعه وكان الله تعالى ولم يكن معه شيء ووافقتهم على ذلك جماعة من أساطين الحكمة وقدماء الفلاسفة مثل تاليس وانكساغورس وانكسمايس ومن تابعهم م أهل ملطية ومثل فيثاغورس وأنبدقلس وسقراط وأفلاطن من أثينية ويونان وجماعة من الشعراء والنساك ولهم تفصيل مذهب في كيفية الإبداع واختلاف رأي في المبادي الأول شرحناها في كتابنا الموسوم بالملل والنحل ومذهب أرسطاطاليس ومن شايعه مثل برقلس والاسكندر الافروديسي وثامسطيوس ومن نصر مذهبه من المتأخرين مثل أبي نصر الفارابي وأبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا وغيرهما من فلاسفة الإسلام أن للعالم صانعاً مبدعاً وهو واجب بذاته والعالم ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بالواجب بذاته غير محدث حدوثاً يسبقه عدم بل معنى حدوثه وجوبه به وصدوره عنه واحتياجه إليه وهو جوهر مجرد قائم بذاته مجرد عن المادة وبتوسط ذلك أوجب عقلاً آخر ونفساً وجرماً سماوياً وبتوسطهما وجدت العناصر والمركبات وليس يجوز أن يصدر عن الواحد إلا واحد ومعنى الصدور عنه وجوبه به ولا يتصور موجب بغير موجب فالعالم سرمدي وحركات الأفلاك سرمدية لا أول لها تنتهي إليه فلا تكون حركة إلا وحركة قبلها فهي لا تتناهى مدة وعدة واتفقوا على استحالة وجود علل ومعلولات لا تتناهى واتفقوا أيضاً على استحالة وجود أجسام لا تنتهي بالفعل والضابط لمذهبهم فيما يتناهى وما لا يتناهى إن كل عدد فرضت آحاده موجودة معاً وله ترتيب وضعي أو فرضت آحاده متعاقبة في الوجود وله ترتيب طبيعي فإن وجود ما لا نهاية له فيه مستحيل.
مثال القسم الأول جسم أو بعد لا يتناهى ومثال القسم الثاني علل ومعلولات لا تتناهى وما عدى ذلك كل جملة وعدد فرضت آحاده معاً أو متعاقبة لا ترتيب لها وضعاً ولا طبعاً فإن وجود ما لا نهاية له فيه غير مستحيل مثال القسم الأول نفوس إنسانية لا تناهى وهي معاً في الوجود بعد مفارقة الأبدان.
ومثال القسم الثاني: حركات دورية وهي متعاقبة في الوجود ومدار المسئلة على الفرق بين الإيجاد والإيجاب وبين التقدم والتأخر وإن ما حصره الوجود فهو متناه من غير فرق بين الأقسام وما لا يتناهى قط لا يتصور إلا في الوهم والتخيل دون الحسن والعقل ولا بد من بحث على محل النزاع حتى يتخلص فيكون التوارد بالنفي والإثبات على محل واحد من وجه واحد فيصبح انقسام الصدق والكذب والحق والباطل ولا يتبين محل النزاع إلا بالبحث عن أقسام التقدم والتأخر فقال القوم التقدم والتأخر يطلق ويراد به التقدم بالزمان كتقدم الوالد على الولد ويطلق ويراد به التقدم بالمكان والتأخر به كتقدم الإمام على المأموم وقد يسمى هذا القسم متقدماً بالرتبة وقد يطلق ويراد به الفضيلة كتقدم العالم على الجاهل وقد يطلق ويراد به التقدم بالذات والتأخر بها كتقدم العلة على المعلول وهؤلاء قصدوا في إطلاق لفظ الذات فإنهم أرادوا به العلية والذات أعم من العلية فكان من حقهم أن يقولوا التقدم بالعلية ثم العلية الغايية تتقدم على المعلول في الذهن والتصور لا في الوجود فهي متأخرة في الوجود متقدمة في الذهن بخلاف العلة الفاعلية والعلل الصورية فإنها لا تكون مقارنة في الوجود فافهم هذا فإنه ينفعك في نفس المسئلة حيث يستشهدون بشعاع الشمس مع الشمس وحركة الكم مع حركة اليد فإنهما وإن تقارنا في الزمان أنهما إذا أخذا على أن أحدهما سبب والثاني مسبب لم يتقارنا في الوجود لأن وجود أحدهما مستفاد من وجود الآخر فوجود المفيد كيف يقارن وجود المستفيد لكن إذا أخذا على أن وجودهما مستفاد من وجود واهب الصور فحينئذ يتقارنان في الوجود وهناك لا يكون أحدهما سبباً والثاني مسبباً ومنهم من زاد قسماً خامساً وهو التقدم بالطبع كتقدم الواحد على الاثنين ولو طالبهم مطالب لم حصرتم الأقسام في أربعة أو خمسة لم يجدوا على الحصر دليلاً سوى الاستقراء حتى لو قيل لهم ما الذي أنكرتم على من زاد قسماً سادساً وهو التقدم والتأخر في الوجود من غير التفات إلى الإيجاب بالذات ولا التفات إلى الزمان والمكان والتقدم للواحد على الاثنين شديد الشبه بهذا القبيل فإن الواحد ليس بعلة يلزم منه وجود الاثنين ضرورة بل يمكن أن يتصور شيآن أحدهما وجوده بذاته والثاني وجوده مستفاد من غيره ثم بعد ذلك يقع البحث في انه يستفيد وجوده منه اختياراً أو طبعاً أو ذاتاً هذا معقول بالضرورة ثم يجب أن يفرض تقدم وجود المفيد على وجود المستفيد من حيث الوجود فقط من غير أن يخطر بالبال كون المفيد علة لذاته أو موجداً له بصفة ثم يقع بعد ذلك التفات إلى أن الوجود المستفيد وجود واجب به لأنه علته أو لا يحب به وذلك لأن الوجوب بالغير لازم به فإنه يحسن أن يقال هذا قد وجد عنه فوجب به ولا يجوز أن يقال وجب به فوجد عنه ولكل معنى من معاني التقدم والتأخر معية في مرتبته لا يجامع التقدم والتأخر في تلك المرتبة ويجامع في مرتبة أخرى مثاله تقدم السبب على المسبب ذاتاً ووجوداً أو مقارنته معاً وزماناً أو مكاناً ولكن لا يجوز أن تطلق معية ما على الباري تعالى والعالم فإذا ثبت هذا قلنا إما التقدم والتأخر الزماني فيجب نفيهما عن الباري تعالى وكما لا يجوز أن يتقدم على العالم زماناً لم يجز أن يكون مع العالم زماناً فإنا كما نفينا التقدم الزماني نفينا المعية الزمانية ومثار الشبهة ومجال الخيال هاهنا فإن فازت سفينة النظر عن هذه الغمرة فاز أهل الحق بقصب السبق في المسئلة فإن ما لا يقبل الزمان ولم يكن وجوده زمانياً لم يجز عليه التقدم والتأخر والمعية الزمانية كما أن ما لا يقبل المكان ولم يكن وجوده وجوداً مكانياً لم يجز عليه التقدم والتأخر والمعية المكانية فقول الخصم إن العالم معه دايم الوجود إيهام بالزمان فيقال يجوز أن يكون موجودان أحدهما متقدم بالذات والآخر متأخر بالذات ويكونان معاً في الزمان فإن التقدم بالذات لا ينافي المعية في الزمان كتقدم السبب على المسبب وحركة اليد على حركة المفتاح في الكم لكن إذا كان وجودهما زمانين فإما وجود لا يقبل الزمان أصلاً كيف يطلق عليه معية بالزمان وذلك كالتقدم بالمكان والمعية به فإن السبب والمسبب قد يكونان معاً في المكان ويسبق أحدهما الآخر بالذات لكن إذا كان وجودهما مكانين فإما وجود لا يقبل المكان أصلاً فكيف يطلق
عليه معية المكان ونحن لا ننكر أن الوهم يرتمي إلى مدة
مقدرة قبل العالم كما يرتمي إلى فضاء مقدر فوق العالم وذلك وهم مجرد وخيال
محض فلا فضاء ولا بينونة كما يقدره الكرامي ولا زمان ولا مدة كما يقدره
الوهمي ولو قدر تقديراً عالم آخر فوق هذا العالم لم يؤد ذلك إلى تجويز ذلك
إلى تجويز عوالم هي أجسام لا تتناهى إذ قد تبين بالبرهان استحالة بعد لا
يتناهى في الملا والخلا وكذلك لو قدر تقديراً عالم آخر قبل هذا العالم لم
يؤد ذلك إلى تجويز عوالم هي متحركات لا تتناهى إذ تبين بالبرهان استحالة
مدة وعدة لا تتناهى فرجع الخلاف إذاً إلى استحالة وجود جسم لا يتناهى
بعداً وبيان استحالة وجود أجسام لا تتناهى زماناً فإن الخصم يسلم التقدم
والتأخر في المعية فإذا سلم التقدم نقول لا يلزم من تقدير جسم لا يتناهى
بعداً وإن كان مستحيلاً أن يكون مع الباري تعالى بالمكان كذلك لم يلزم من
تقدير حركات لا تتناهى زماناً أن تكون مع الباري تعالى بالزمان فإنه تعالى
غير قابل للزمان والمكان وكان الله ولم يكن معه شيء إذ لم تكن معية بالذات
ولا بالوجود ولا بالرتبة المكانية والزمانية ولم يلزم من إطلاق كونه
موجداً أن يكون الموجد معه في الوجود ولا لزم من إطلاق كونه موجباً أن
يكون الموجب معه في الوجود فإن الوجود المستفاد لا يكون مع الوجود المفيد
وكان المعية من كل وجه وعلى كل معنى من الأقسام منفياً عنه سواء أطلقناها
في قسم واحد أو في قسمين مركبين ونحن نبدأ بطرق المتكلمين ثم نعود إلى ما
ذكرناه من الكلام على محل النزاع. معية المكان ونحن لا ننكر أن الوهم
يرتمي إلى مدة مقدرة قبل العالم كما يرتمي إلى فضاء مقدر فوق العالم وذلك
وهم مجرد وخيال محض فلا فضاء ولا بينونة كما يقدره الكرامي ولا زمان ولا
مدة كما يقدره الوهمي ولو قدر تقديراً عالم آخر فوق هذا العالم لم يؤد ذلك
إلى تجويز ذلك إلى تجويز عوالم هي أجسام لا تتناهى إذ قد تبين بالبرهان
استحالة بعد لا يتناهى في الملا والخلا وكذلك لو قدر تقديراً عالم آخر قبل
هذا العالم لم يؤد ذلك إلى تجويز عوالم هي متحركات لا تتناهى إذ تبين
بالبرهان استحالة مدة وعدة لا تتناهى فرجع الخلاف إذاً إلى استحالة وجود
جسم لا يتناهى بعداً وبيان استحالة وجود أجسام لا تتناهى زماناً فإن الخصم
يسلم التقدم والتأخر في المعية فإذا سلم التقدم نقول لا يلزم من تقدير جسم
لا يتناهى بعداً وإن كان مستحيلاً أن يكون مع الباري تعالى بالمكان كذلك
لم يلزم من تقدير حركات لا تتناهى زماناً أن تكون مع الباري تعالى بالزمان
فإنه تعالى غير قابل للزمان والمكان وكان الله ولم يكن معه شيء إذ لم تكن
معية بالذات ولا بالوجود ولا بالرتبة المكانية والزمانية ولم يلزم من
إطلاق كونه موجداً أن يكون الموجد معه في الوجود ولا لزم من إطلاق كونه
موجباً أن يكون الموجب معه في الوجود فإن الوجود المستفاد لا يكون مع
الوجود المفيد وكان المعية من كل وجه وعلى كل معنى من الأقسام منفياً عنه
سواء أطلقناها في قسم واحد أو في قسمين مركبين ونحن نبدأ بطرق المتكلمين
ثم نعود إلى ما ذكرناه من الكلام على محل النزاع.
فنقول للمتكلمين طريقان في المسئلة أحدهما إثبات حدث العالم والثاني إبطال
القول بالقدم.
أما
الأول فقد سلك عامتهم طريق الإثبات بإثبات الإعراض أولاً وإثبات حدثها
ثانياً وبيان استحالة خلو الجواهر عنها ثالثاً وبيان استحالة حوادث لا أول
لها رابعاً ويترتب على هذه الأصول أن ما لا يسبقه الحوادث فهو حادث وقد
أوردوا هذه الطريقة في كتبهم أحسن إيراد.
وأما الثاني فقد سلك شيخنا
أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه طريق الإبطال وقال لو قدرنا قدم الجواهر
لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون مجتمعة أو مفترقة أو لا مجتمعة ولا
مفترقة أو مجتمعة ومفترقة معاً أو بعضها مجتمع وبعضها مفترق وبالجملة ليست
تخلو عن اجتماع وافتراق أو جواز طريان الاجتماع والافتراق وتبدل أحدهما
بالثاني وهي بذواتها لا تجتمع ولا تفترق لأن حكم الذات لا يتبدل وهي قد
تبدلت فإذاً لا بد من جامع فارق فيترتب على هذه الأصول أن ما لا يسبق
الحادث فهو حادث وقد أخذ الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني هذه الطريقة وكساها
عبارة أخرى وربما سلك أبو الحسن رحمه الله طريقاً في إثبات حدوث الإنسان
وتكونه من نطفة أمشاج وتقلبه في أطوار الخلقة وأكوار الفطرة ولسنا نشك في
أنه ما غير ذاته ولا بدل صفاته ولا الأبوان ولا الطبيعة فيتعين احتياجه
إلى صانع قديم قادر عليم قال وما ثبت من الأحكام لشخص واحد أو لجسم واحد
ثبت في الكل في الجسمية وهذه الطريقة تجمع الإثبات والإبطال واعتمد إمام
الحرمين رضي الله عنه طريقة أخرى فقال الأرض عند خصومنا محفوفة بالماء
والماء بالهواء والهواء بالنار والنار بالأفلاك وهي أجرام متحيزة شاغلة
جواً وحيزاً وبالاضطرار نعلم أن فرض هذه الأجسام متيامنة عن مقرها أو
متياسرة أو أكبر مما وجدت شكلاً وعظماً أو أصغر من ذلك ليس من المستحيلات
وكل مختص بوجه من وجوه الجواز دون ساير الوجوه مع استواء الجايزات وتماثل
الممكنات احتاج إلى مخصص بضرورة العقل وستعلم فيما بعد أن العالم ممكن
الوجود باعتبار ذاته سواء قدر كونه متناهياً في ذاته مكاناً أو زماناً أو
غير متناه فإن الخصم يقضي عليه بالإمكان على انه في ذاته غير متناهي
الزمان وهو متناهي المكان فالأولى أن يجعل للتناهي المكاني مسئلة ويجعل
للتناهي الزماني من حيث الحركات والمتحركات مسئلة أخرى ونأخذ احتياجه إلى
المخصص كالمسلم أو كالضروري أو كالقريب من الضروري.
فإن قيل فما الدليل
على تطرق وجود الجايزات إلى العالم بأسره قلنا العقل الصريح يقضي بالإمكان
في كل واحد من أجزاء العالم والمجموع إذا كان مركباً من الأجزاء كان
الإمكان واجباً له ضرورة.
فإن قيل فما الدليل على أن الأجسام متناهية من حيث الذات
قلنا
لو قدرنا جسماً لا يتناهى أو بعداً لا يتناهى فإما أن يكون ذلك الجسم غير
متناه من جميع الجهات أو من جهة واحدة وعلى أي وجد قدر فيمكن أن يفرض فيه
نقطة متناهية يتصل بها خط لا يتناهى ويمكن أن تفرض نقطة أخرى على خط هو
أنقص من الأول بذراع ونصل بين النقطتين بحيث يطبق الخط الأصغر على الخط
الأطول فإن كان كل واحد من الخطين تمادى إلى غير نهاية فيكون الخط الأصغر
مساوياً للخط الأطول وهو محال وإن قصر الأقصر عن الأطول بمتناه فقد تناهى
الأقصر وتناهى الأطول إذ قصر عنه الأقصر بمتناه وزاد الأطول عليه بمتناه
وما زاد على الشيء بمتناه كان متناهياً وعلى كل حال فإن كان أحدهما أكبر
من الثاني كان فيما لا يتناهى ما هو أصغر وأكبر وأكثر وأقل وذلك محال فعلم
أن جسماً لا يتناهى محال وجوده وإن بعداً لا يتناهى في خلا أو ملا محال
ويمكن أن ينقل هذا البرهان بعينه إلى أعداد وأشخاص لا تتناهى حتى يتبين أن
فرض ذلك محال فإذا قضينا على الجسم بالتناهي وجاز أن يكون أكبر منه وأصغر
وإذا تخصص أحد الجايزين احتاج إلى المخصص وكما يمكن فرض الجواز في الصغر
والكبر يمكن فرضه في التيامن والتياسر فإن الجواز العقلي لا يقف في
الجايزات ثم المخصص لا يخلو إما أن يكون موجباً بالذات مقتضياً بالطبع
وإما أن يكون موجداً بالقدرة والاختيار والأول باطل فإن الموجب بالذات لا
يخصص مثلاً عن مثل إذ الإحياز والجهات والأقدار والأشكال وساير الصفات
بالنسبة إليه واحدة وهي في ذواتها متماثلة إذ لا طريق لنا إلى إثبات
الصانع إلا بهذه الأفعال وقد ظهر فيها آثار الاختيار لتخصيصها ببعض
الجايزات دون البعض فعلمنا قطعاً ويقيناً أن الصانع ليس ذاتاً موجباً بل
موجداً عالماً قادراً وهذه الطريقة في غاية الحسن والكمال إلا أنها محتاجة
إلى تصحيح مقدمات ليحصل بها العلم بحدث العالم واحتياجه إلى الصانع منها
إثبات نهاية الأجرام في ذواتها ومقاديرها ومنها إثبات خلا وراء العالم حتى
يمكن فرض التيامن والتياسر فيه ومنها نفي حوادث لا أول لها فإن الخصم ربما
يقول بموجب الدليل كله ويسلم أن العالم ممكن الوجود في ذاته وأنه محتاج
إلى مخصص مرجح لجانب الوجود على العدم ومع ذلك يقول هو دايم الوجود به
ومنها حصر المحدثات في الإجرام والقايم بالإجرام وقد أثبت الخصم موجودات
خارجة عن القسمين هي دائمة الوجود بالغير دواماً ذاتياً لا زمانياً
ووجوداً جوهرياً لا مكانياً بحيث لا يمكن فرض التيامن والتياسر والصغر
والكبر فيها ولا تتطرق الأشكال والمقادير إليها ومنها إثبات أن الموجب
بالذات كالمقتضى بالطبع فإن الخصم لا يسلم ذلك ويفرق بين القسمين والأولى
أن تفرض المسئلة على قضية عقلية يوصل إلى العلم بها بتقسيم داير بين النفي
والإثبات.
فنقول القسمة العقلية حصرت المعلومات في ثلثة أقسام واجب
ومستحيل وجايز فالواجب هو ضروري الوجود بحيث لو قدر عدمه لزم منه محال
والمستحيل هو ضروري العدم بحيث لو قدر وجوده لزم منه محال والجايز ما لا
ضروري في وجوده ولا عدمه والعالم بما فيه من الجواهر العقلية والأجسام
الحسية والأعراض القايمة بها قدرناه متناهياً وغير متناه وكذلك لو قدرنا
انه شخص واحد أو أشخاص وأنواع كثيرة إما أن يكون ضروري الوجود أو ضروري
العدم وذلك محال لأن أجزاءه متغيرة الأحوال عياناً وضروري الوجود على كل
حال لا يتغير بحال.
فوجه تركيب البرهان منه أن نقول كل متغير أو
متكثر فهو ممكن الوجود باعتبار ذاته وكل ممكن الوجود باعتبار ذاته فوجوده
بإيجاد غيره فكل متغير أو متكثر فوجوده بإيجاد غيره وأيضاً فإن الكل متركب
من الآحاد والآحاد إذا كان كل واحد منها ممكن الوجود فالكل واجب أن يكون
ممكن الوجود وكل ممكن فهو باعتبار ذاته جايز أن يوجد وجايز أن لا يوجد
وإذا ترجح جانب الوجود على العدم احتاج إلى مرجح والمرجح يستحيل أن يكون
مرجحاً باعتبار ذاته ومن حيث وجوده فقط لأمور أحدها أن الوجود من حيث هو
وجود أمر يعم الواجب والجايز وهو فيهما بمعنى واحد لا يختلف فلو أوجد من
حيث أنه وجود أو من حيث أنه ذات لما كان أحد الموجودين أولى بالإيجاد من
الثاني فيتعين أنه يوجد لكونه وجوداً على صفة أو ذاتاً على صفة ويدل على
ذلك الأمر الثاني وهو أن وجوه الجواز قد تطرقت إلى الأفعال وتلك الوجوه
متماثلة والموجب لا يخصص مثلاً عن مثل فإن نسبة أحد المثلين إليه كنسبته
إلى المثل الثاني فإذا خصص أحد المثلين دون الثاني علم أن الإيجاب الذاتي
باطل فإن منعوا تلك الوجوه فلا شك أن الجايز بنفسه يتساوى طرفاه ونسبة
الذات من حيث هو ذات إلى أحد طرفيه كنسبته إلى الطرف الثاني فإذا تخصص
بالوجود دون العدم فلا بد من مخصص وراء كونه ذاتاً وبطل الإيجاب بالذات
والثالث أن الموجب بالذات ما لم يناسب الموجب بوجه من وجوه المناسبة لم
يحصل الموجب وذلك أنا إذا تصورنا ذاتين أو أمرين معلومين لا اتصال لأحدهما
بالآخر ولا مناسبة بينهما ولا تعلق ولا أشعار بل اختص كل واحد منهما
بحقيقته وخاصته لم يقض العقل بصدور أحدهما عن الثاني وواجب الوجود لذاته
ذات قد تعالى وتقدس عن جميع وجوه المناسبات والتعلق والاتصال بل هو منفرد
بحقيقته التي هي له وهي وجوب وجوده ولا صفة له ثانية تزيد على ذاته
الواجبة فلا يلزم أن يوجد عنه شيء بحكم الذات فإيجاب الذات غير معقول
أصلاً بعد رفع النسب والعلائق وعن هذا قلتم أن الموجب لما كان واحداً
استحال أن يصدر عنه شيئان معاً ولما كان عقلاً أي مجرداً عن المادة أوجب
عقلاً بالفعل مجرداً عن المادة ولما اقتضى الإيجاب مناسبة والمناسبة تقتضي
المماثلة حتى ينوب أحد المثلين مناب الثاني ثبت لواجب الوجود مثل ثبوت
مناب واجب الوجود في الإيجاب فعرف أن الإيجاب الذاتي باطل فتعين الإيجاد
الاختياري وذلك ما أردنا أن نورد.
فإن قيل إما كون العالم جايز الوجود
واحتياجه إلى واجب الوجود فمسلم لكن لم قلتم إن كونه موجوداً بغيره يستدعي
حدوثه عن عدم فإن وجود الشيء بالشيء لا ينافي كونه دايم الوجود به وإنما
يتبين هذا بأن نبحث في الموضع المتفق انه إذا أحدثه عن عدم هل كان سبق
العدم شرطاً في تحقق الأحداث.
قلنا لا يجوز أن يكون شرطاً فإن المحدث
ما استند إلى المحدث إلا من حيث وجوده فقط والعدم لا تأثير له في صحة
الإيجاد فيجوز أن يكون دايم الوجود بغيره.
والجواب قلنا الواجب أن نزيل عن الكلام ما يوقعه الوهم حتى يتجرد المعقول الصرف عن العقل فقول القائل وجد عن عدم أو بعد العدم أو سبقه العدم إن كان يعني به أن العدم شيء يتحقق له سبق وتقدم وتأخر واستمرار وانقطاع أو شيء يوجد عنه شيء فذلك كله من إيهام الخيال حيث لم يمكنه تصور الأولية في الشيء الحادث إلا مستنداً إلى شيء موهوم كالزمان والمدة كما لم يمكنه تصور النهاية في العالم إلا مستنداً إلى شيء موهوم كالخلا والفضا وكما لم يمكن فرض خلاء بين وجود الباري تعالى وبين العالم لا يمكن أيضاً فرض زمان وتقدير زمان بين وجود الباري تعالى وبين العالم فإن ذلك من عمل الوهم فقط ولا يلزم منه المعية بالزمان كما لا يلزم المعية من المكان فافهم ذلك فيجب أن تزيل هذا الإيهام عن فكرك فيتصور أن وجود شيء لا من شيء هو المعني بحدوث الشيء عن العدم فإن قولنا له أول المعنى بحدوثه وإن قولنا لم يكن فكان هو المعنى بسبق العدم إذ لا بد من عبارة وتوسع في الكلام ليطلق لفظ السبق والتأخر والاستمرار والانقطاع وإذا ثبتت هذه القاعدة فنقول إذا كان العالم ممكن الوجود باعتبار ذاته والممكن معناه أنه جايز الوجود وجايز العدم فيستوي طرفاه أعني الوجود والعدم باعتبار ذاته فإذا وجد فإنما يوجد باعتبار موجده ولولا موجده لما استحق إلا العدم فهو إذاً مستحق الوجود والعدم بالاعتبارين المذكورين فكان واجب الوجود سابقاً عليه بالذات والوجود إذ لولاه لما وجد ولا يجوز أن يكون وجوده مع واجب الوجود بالذات والوجود جميعاً لأن قبل ومع بالذات والوجود لا يجتمعان في شيء واحد فهو إذاً متأخر الوجود ولا يجوز أن يكون مع واجب الوجود بالزمان لأنه يوجب أن يكون واجب الوجود زمانياً لأن قولنا مع من جملة المتضايفات كالأخوة والأبوة فأحد الشيئين إذا كان مع الثاني بالزمان كان الثاني معه أيضاً بالزمان وبكل اعتبار أثبت المعية في أحد الشيئين وجب عليك أن تثبتها في الشيء الثاني ولا يجوز أن يكون وجوده مع واجب الوجود بالرتبة والفضيلة لأن رتبة الواجب بذاته لا يكون كرتبة الواجب بغيره وظهر أن جايز الوجود وواجب الوجود لا يكونان معاً بوجه من الوجوه واعتبار من الاعتبارات وصح القول كان الله ولم يكن معه شيء فما معنى قولكم الجايز دايم الموجود بالواجب أو مع الواجب أو قدرتم دوام وجود الباري تعالى زمانياً ممتداً مع الأزمنة الغير المتناهية كما توهمتم وجود العالم زمانياً ممتداً في أزمنة لا تتناهى وبئس الوهم وهمكم في الدوامين فكأنكم أخذتم لفظ الدوام بالاشتراك المحض أما دوام وجود الباري تعالى فمعناه انه واجب لذاته وبذاته ولا يتطرق إليه جواز ولا عدم بوجه من الوجوه فهو الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر كان بعده وأوله آخره وآخره أوله أي ليس وجوده زمانياً وأما العالم فله أول ودوامه دوام زماني يتطرق إليه الجواز والعدم والقلة والكثرة والاستمرار والانقطاع فلو كان دايم الوجود بدوام الباري كان الباري دايم الوجود بدوام العالم فلو كان الدوامان بمعنى واحد فيلزم أن يكون وجود الباري تعالى زمانياً أو وجود العالم ذاتياً وكلا الوجهين باطل فبطل قولكم إن العالم دايم الوجود بالواجب وإنما يتضح هذا البطلان كل الوضوح إذا أثبتنا استحالة حوادث لا أول لها ووجود موجودات لا تتناهى وأما قولكم إن العالم في المحل المتفق عليه إنما يستند إلى الموجد من حيث وجوده فقط والعدم لا تأثير له في صحة الإيجاد قلنا ولو استند إلى الموجد من حيث وجوده فقط لاستند كل موجود وتسلسل القول إلى ما لا يتناهى ولم يستند إلى واجب وجوده بل إنما استند إليه من حيث جوازه فقط والجواز قضية أخرى وراء الوجود والعدم ثم جواز الوجود سابق على الوجود بالذات فنقول إنما وجد به لأنه كان جايز الوجود ولا نقول إنما كان جايز الوجود لأنه وجد فجواز وجوده ذاتي له والوجود عرضي والذاتي سابق على العرضي سبقاً ذاتياً ثم بينا أن الجايز مستحق العدم باعتبار ذاته لولا موجده فكان مسبوقاً بوجوده ومسبوقاً بعدم ذاته لولا موجده لأن استحقاق وجوده عرضي مأخوذ من الغير واستحقاق عدمه ذاتي مأخوذ من ذاته فهو إذاً مسبوق بوجود واجب ومسبوق بعدم جايز فتحقق له أول والجمع بين ما له أول وبين ما لا أول له محال.
فإن قيل فما الفرق بين وجوب
العالم بإيجاب الباري تعالى وبين وجوده بإيجاد الباري تعالى فإن العالم
إذا كان ممكناً في ذاته ووجد بغيره فقد وجب به وهذا حكم كل علة ومعلول
وسبب ومسبب فإن المسبب أبداً يجب بالسبب فيكون جايزاً باعتبار ذاته واجباً
باعتبار سببه ثم السبب يتقدم المسبب بالذات وإن كانا معاً في الوجود كما
تقول تحركت يدي فتحرك المفتاح في كمي ولا يمكنك أن تقول تحرك المفتاح في
كمي فتحركت يدي وإن كانت الحركتان معاً في الوجود.
والجواب قلنا وجود
الشيء بإيجاد موجده صواب من حيث اللفظ والمعنى بخلاف وجوب الشيء بإيجاب
الموجب وذلك أن الممكن معناه انه جايز وجوده وجايز عدمه لا جايز وجوبه
وجايز امتناعه وإنما استفاد من المرجح وجوده لا وجوبه نعم لما وجد عرض له
الوجوب عند ملاحظة السبب لأن السبب إفادة الوجوب حتى يقال وجب بإيجابه ثم
عرض له الوجوب بل أفاده الوجود وفصح أن يقال وجد بإيجاده وعرض له الوجود
فانتسب إليه وجوده إذ كان ممكن الوجود لا ممكن الوجوب وهذه دقيقة لطيفة لا
بد من مراعاتها والذي نثبته أن الواجب والممتنع طرفان والممكن واسطة إذ
ليس بواجب ولا ممتنع فهو جايز الوجود وجايز العدم والوجود والعدم متقابلان
لا واسطة بينهما والذي يستند إلى الموجد من وجهين الوجود والعدم في الممكن
وجوده فقط حتى يصح أن يقال أوجده أي أعطاه الوجود ثم لزمه الوجوب لزوم
العرضيات فالأمر اللازم العرضي لا يستند إلى الموجد فأنتم إذا قلتم وجب
وجوده بإيجابه فقد أخذتم العرضي ونحن إذا قلنا وجد بإيجاده فقد أخذنا عين
المستفاد الذاتي فاستقام كلامنا لفظاً ومعنىً وانحرف كلامكم عن سنن الجادة
ولربما نقول أن الممكن إذا وجد في وقت معين أو على شكل مخصوص يجب وجوده
على ذلك الوجه لأن الموجد إذا علم حصوله في ذلك الوقت على ذلك الشكل وأراد
ذلك فهو واجب الوقوع لأن خلاف المعلوم مستحيل الوقوع والحصول وإذا كان
ممكن الجنس جايز الذات لكن لم يكن وجوب ذلك إلا بإيجاب العلم والإرادة
فإذا تحقق أن الوجود هو المستفاد في الحوادث لا الوجوب بطل الإيجاب الذاتي
الذي يتحجوا به حين بنوا عليه مقارنة وجود العالم بوجود الباري تعالى ولم
يبق لهم إلا التمثيل بمثال وذلك من سخف المقال لأن الخصم ربما لا يسلم أن
حركة اليد سبب حركة الكم والمفتاح ولا يقول بالتولد يبقى مجرد فاء التعقيب
والتسبيب لفظاً في قوله تحركت يدي فتحرك المفتاح وهذا كما أن المادة عند
الخصم سبب ما لوجود الصورة حتى يصح أن يقال لولا المادة لما وجدت الصورة
وهما معاً في الوجود وليس وجود الصورة بإيجاد المادة بل بإيجاد واهب الصور
ثم إن سلم ذلك فيجوز أن يسبق السبب المسبب ذاتاً ويقارنه زماناً فيكون
زمان وجودهما واحداً وأحدهما سبب والثاني مسبب كما يقال في الاستطاعة مع
الفعل لكن الممتنع وجود ما له أول مع وجود ما لا أول له وقد بينا أن هذه
المعية ممتنعة على الوجود كلها أعني بالذات والوجود والزمان والرتبة
والفضيلة فإن التقدم والتأخر والمع يطلق على الشيئين إذا كانا متناسبين
نوعاً من المناسبة ولا نسبة بين الباري تعالى وبين العالم إلا بوجه الفعل
والفاعلية والفاعل على كل حال متقدم والمفعول متأخر يبقى أن يقال هل كان
يجوز أن يخلق العالم قبل ما خلقه بحيث يكون نسبة بدوه إلى وقتنا أكثر
زمانا فيجاب عنه أن إثبات الأولية والتناهي للعالم واجب تصوره عقلاً إذ
البرهان قد دل عليه وما وراء ذلك تقدير وهمي يسمى تجويزاً عقلياً
والتقديرات والتجويزات لا تقف ولا تتناهى وهو كما إذا سئلتم هل كان يجوز
أن يحدث العالم أكبر مما خلقه بحيث يكون نسبة نهايته إلى مكاننا أكبر
مسافةً فيجاب عنه إن إثبات الحد والتناهي للعالم واجب تصوره عقلاً إذ
البرهان قد دل عليه وما وراء ذلك فتقدير ذهني يسمى تجويزاً عقلياً
والتقديرات والتجويزات لا تتناهى فتقدير مكان وراء العالم مكاناً كتقدير
زمان وراء العالم زماناً وبالجملة حدث العالم حيث يتصور الحدوث والحادث ما
له أول والقديم ما لا أول له والجمع بين ما له أول وبين ما لا أول له محال
هذا ما نعقله من الحدوث ضرورة وهو كتناهي العالم من الحجمية والجسمية حذو
القدة بالقدة.
فإن قيل قد دل البرهان العقلي على أن جسماً ما لا
تتناهى ذاته بالفعل مستحيل وجوده فبينوا أن حركات متعاقبة وحوادث متتالية
لا تتناهى مستحيل وجودها فإن عندنا التناهي واللاتناهي إنما يتطرق إلى
أربعة أقسام اثنان منها لا يجوز أن يوجدا غير متناهيين الذات وهو ما له
ترتيب وضعي كالجسم أو طبيعي كالعلل فجسم لا تتناهى ذاته مستحيل وجوده وعلل
ومعلولات لا تتناهى بالعدد مستحيل وجودها أيضاً ولكل واحد من القسمين
ترتيب في الوجود أما الجسم فله ترتيب وضعي ولأجزائه اتصال ولكل جزء منه
إلى جزء نسبة فلا يجوز وجود جسم غير متناه في زمان واحد وأما العلل فلها
ترتيب طبيعي فإن المعلول يتعلق بعلته ولكل معلول إلى علته نسبة فلا يجوز
وجود جسم وعلل ومعلولات لا تتناهى وأما القسمان اللذان يوجدان غير متناهيي
الذات فإن أحدهما الحوادث والحركات التي لا تترتب بعضها على بعض لضرورة
ذاتها بل تتعاقب وتتوالى شيء بعد شيء في أزمنة غير متناهية فإن ذلك جايز
عقلاً والثاني النفوس الإنسانية فإنها موجودات لم تتعاقب بل هي مجتمعة في
الوجود ولكن لا ترتيب لها وضعاً كالجسم ولا طبعاً كالعلل فيجوز أن توجد
غير متناهية.
والجواب قلنا كلما حصره الوجود وكان قابلاً للنهاية فهو
متناه ضرورة وما لا يتناهى لا يتصور وجوده سواء كان له ترتيب وضعي أو
طبيعي أو لم يكن.
والبرهان على ذلك بحيث يعم الأقسام الأربعة أن كل
كثرة لا تتناهى فلا تخلو إما أن تكون غير متناهية من وجه أو غير متناهية
من جميع الوجوه والجهات وعلى القسمين جميعاً فإنا يمكننا أن نفصل منهما
جزءاً بالوهم أو بالعقل فنأخذ تلك الكثرة مع ذلك الجزء شيئاً على حدة
ونأخذها بانفرادها شيئاً على حدة فلا يخلو إما أن تكون تلك الكثرة مع تلك
الزيادة مساوية للكثرة من غير الزيادة عدداً أو مساحة فيلزم أن يكون
الزائد مثل الناقص ومساوياً له وهذا محال وإما أن لا يكون مساوياً له
فيلزم أن يكون كثرتان غير متناهيتين وإحداهما أكبر والثانية أنقص وهو
أيضاً محال وهذا البرهان إن فرضته في جسم غير متناه من جميع الجهات أو من
جهة واحدة فالعبارة عنه أن نقول لك أن تفرض نقطة من ذلك الجسم ويفصل منه
مقداراً فتأخذ ذلك الجسم مع ذلك المقدار شيئاً على حدة وبانفراده شيئاً
على حدة ثم نطبق بين النقطتين المتناهيتين في الوهم فلا يخلو إما أن يكونا
بحيث يمتدان معاً مطابقين في الامتداد إلى ما لا يتناهى فيكون الزائد
والناقص متساويين وإما أن لا يمتدا بل يقصر أحدهما عنه فيكون متناهياً
والقدر المفضول كان متناهياً أيضاً فيكون المجموع متناهياً أيضاً وقد فرضه
غير متناه هذا خلف وكذلك إن فرضته في حركات غير متناهية أو أشخاص غير
متناهية متعاقبة أو مجتمعة أو تفرض نفوساً غير متناهية معاً أو مجتمعة في
الوجود فالعبارة عنه أن نقول لك أن تفرض حركة واحدة أو شخصاً واحداً وتفصل
من الحركات أو الأشخاص مقداراً بالتوهم وتنسب الحركات الزائدة إلى الحركات
الناقصة وتم البرهان من غير تفاوت بين الصورتين.
قال أبو علي بن سينا
ها هنا فرق وهو أن الجسم له ترتيب وضعي أمكنك أن تعين فيه نقطة ثم ترتب
عليها جواز الانطباق والامتداد إلى ما لا يتناهى وليس للحركات المتتالية
ترتيب وضعي فإنها ليست معاً في زمان واحد فلا يمكنك أن تعين فيها حركة
واحدة وترتب عليها جواز الانطباق لأن ما لا يترتب في الوضع أو الطبع فلا
يحتمل الانطباق.
قيل له جوابك عن هذا الفرق من وجهين أحدهما أنك
فرضت النقطة في الجسم والامتداد إلى ما لا يتناهى بالوهم وقدرت التطبيق
أيضاً بالوهم فقدر وهما أن الحركات الماضية كأنها موجودة متعاقبة والأزمنة
أيضاً كأنها موجودة وهماً متعاقبة على مثال خط موهوم لا يتناهى تركب من
نقط متتالية والحدود في الحركات والأوقات في الأزمنة كالنقط في الخطوط
والتعاقب كالتتالي والعلة التي لأجلها امتنع اللاتتناهي ووجب أن تتناهى
فهو أنه مود إلى أنه يكون الأقل مثل الأكثر والناقص مثل الزايد وهذا موجود
في الموضعين جميعاً ولذلك قال المتكلم أنا إذا فرضنا الكلام في اليوم الذي
نحن فيه وقلنا ما مضى من الأيام غير متناه عندكم وما بقي أيضاً غير متناه
والباقي والماضي متساويان متماثلان في عدم التناهي فلو فصلنا من الماضي
سنةً وأضفناها إلى الباقي صار الماضي ناقصاً والباقي زايداً وهما متماثلان
في نفي التناهي أدى ذلك إلى أن يكون الزايد مثل الناقص.
الوجه الثاني
أنه لو لم يتحقق في الحركات والأشخاص ترتيب وضعي فقد تحقق فيها ترتيب
طبيعي كالعلل والمعلولات فإنها لا بد أن تكون متناهية بالاتفاق وذلك أن كل
معلول فهو ممكن الوجود بذاته وإنما يجب وجوده بعلته فيتوقف وجوده على وجود
علته والكلام في علته كذلك حتى يتناهى إلى علة أولى ليست ممكنة لذاتها
كذلك نسبة كل والد إلى مولود نسبة العلة إلى معلولها فيتوقف وجود الولد
على وجود الوالد وكذلك القول في الوالد فهلا قلت ينتهي إلى والد أول ومع
ذلك فالأشخاص عندكم لا تتناهى ثم يعدد لكل شخص إنساني قد وجد نفس ناطقة
وهي باقية مجتمعة في الوجود فالأشخاص إذا كانت لا تتناهى وجاز وجودها
لأنها متعاقبة لا مجتمعة معاً في الوجود فما قولك في النفوس فإنها مجتمعة
وهي لا تتناهى فإن قال ليس لها ترتيب طبيعي ولا وضعي قيل إذا ترتبت
الأشخاص والداً ومولوداً ترتبت النفوس أيضاً ذلك الترتيب لأن من العوارض
واللوازم المعينة للنفوس كونها بحيث إن صدرت عن أشخاصها أشخاص فهذه النسبة
باقية ببقائها ولذلك النوع ترتيب.
برهان آخر في أن ما لا يتناهى من
الحوادث والحركات لا يتحقق في الوجود: وذلك أنا نفرض الكلام في الدورة
التي نحن فيها ولا شك أن ما مضى قد انتهى بها وما انتهى بشيء فقد تناهى
ومعنى قولنا أن ما مضى قد انتهى أنا إذا أردنا قصر النظر على ما نحن فيه
وقطعناه عما سيأتي اقتضى ذلك تناهي الحركات الماضية إذ يتناهى الحركات
الماضية لم يكن مشروطاً فيها لحوق الحركات الآتية فما من حركة توجد وتعدم
إلا وقد انقضت حركات قبلها بلا نهاية فيوجد أبداً طرف منها متناهياً ويكون
ذلك الطرف آخر الماضي وأولاً لما بقي فكل حركة أو كل دورة فقد تحقق لها
أول وآخر وإذا تناهى من طرف فقد تناهى من الطرف الثاني فالحركات كلها إذاً
في ذواتها متناهية أولاً وآخراً وهي معدودة بالزمان والزمان هو العاد
للحركات فالمعدود إذاً يتناهى أولاً وآخراً كذلك يلزم أن يتناهى العاد
أولاً وآخراً يبقى أن يقال أهي متناهية عدداً أم لا قلنا وكل عدد موجود
فهو قابل للزيادة والنقصان والأكثر والأقل فهو متناه وكل عدد موجود فهو
متناه وهذا الحكم يجري في كل عدد موجود معاً كالنفوس الإنسانية أو متعاقبة
كالأشخاص الإنسانية وعندهم النفوس غير متناهية عدداً وهي قابلة للزيادة
والنقصان فإذا طبقت الأشخاص على النفوس تساوت لا محالة وإن نقصت من
الأشخاص عدداً وطبقت الباقي على عدد النفوس فإن كان كل واحد منهما لا
يتناهى كان الزائد مثل الناقص وإن كان يتناهى فقد حصل المقصود وتطبيق الخط
على الخط كتطبيق العدد على العدد وتطبيق النفس على الشخص والحركات
والمتحركات إذا تناهت ذاتاً وزماناً ومكاناً وعدداً وهذا قاطع لا جواب عنه
ولا سؤال عليه.
ومن جملة الإلزامات على الدهرية أن حركات زحل وهو في
الفلك السابع مثل حركات القمر وهو في الفلك الأول من حيث أن كل واحد من
النوعين غير متناه ومعلوم بالضرورة أن حركات زحل أكثر من حركات القمر فهي
إذاً مثلها وأكثر منها وذلك من أمحل المحال وأبلغ في التناقض.
فإن قيل
إن قصرت مسافة فلك القمر عن فلك زحل فقد طال زمان القمر بمقدار قصر
المسافة حتى قطع القمر فلكه بمثل ما قطع زحل فلكه فقد تساويا في الحركة.
قلنا
وما قولكم في حركة فلك زحل فإنها حركات المحيط وحركات فلك القمر حركات
القطب فهما متساويان فيما لا يتناهى وحركات فلك زحل أضعاف حركات فلك القمر
ولا جواب عنه.
فإن قيل ألستم أثبتم تفاوتاً في معلولات الله تعالى وفي
مقدوراته فإن العلم عندكم متعلق بالواجب والجايز والمستحيل والقدرة لا
تتعلق إلا بالجايز فكانت المعلومات أكثر والمقدورات أقل والقلة والكثرة قد
تطرقتا إلى النوعين وهما غير متناهيين.
والجواب قلنا نحن لم نثبت
معلومات أو مقدورات هي أعداد بلا نهاية بل معنى قولنا أنها لا تتناهى أي
العلم صفة صالحة يعلم به ما يصح أن يعلم والقدرة صفة صالحة يقدر بها على
ما يصح أن يوجد ثم ما يصح أن يعلم وما يصح أن يقدر عليه لا يتناهى وليس
ذلك عدد أنقص من عدد حتى يكون ذلك نقضاً لما ذكرناه وإنما الممتنع عندنا
أعداد يحصرها الوجود وهي غير متناهية فنقول قد بينا أن ما لا يتناهى إنما
يمكن تصوره في الوهم والتقدير لا في الوجود كالعدد يقال له أنه لا ينتهي
تضعيفاً وليس نعني به أن العدد الغير متناه موجود محصور بل المعنى أنك إذا
قدرت أو توهمت ضعفاً فوق ضعف إلى ما لا يتناهى أمكنك ذلك كذلك المعلولات
والمقدورات على التقدير الوهمي لا يتناهى ولصلاحية العلم أن يعلم به كل ما
يصح أن يعلم ويخبر عنه يقال أن العلم لا يتناهى وكذلك لصلاحية القدرة أن
يقدر بها على كل ما يصح أن يقدر عليه يقال إن القدرة لا تتناهى فلا القدرة
ولا العلم أمر بسيط ذاهب في الجهات لا يتناهى ولا المعلومات والمقدورات
أعداد كثيرة لا تتناهى وهكذا ينبغي أن تفهم من معنى قولنا ذات الباري
سبحانه لا تتناهى أي هو واحد لا يقبل الانقسام بوجه من الوجوه فلا يتطرق
إليه نهاية بوجه من الوجوه.
شبه الدهرية قالوا إذا قلتم أن العالم محدث
بعد أن لم يكن فقد تأخر وجوده عن وجود الباري تعالى فلا يخلو إما أن يتأخر
بمدة أو لا بمدة فإن تأخر لا بمدة فقد قارن وجوده وجود الباري سبحانه وإن
تأخر بمدة فلا يخلو إما إن تأخر بمدة متناهية أو بمدة غير متناهية فإن
تأخر بمدة متناهية فقد وجب تناهي وجود الباري تعالى وإن تأخر بمدة غير
متناهية فنفرض في تلك المدة موجودات لا تتناهى فإنه إن لم يمتنع مدة لا
تتناهى لم يمتنع لم يمتنع عدة لا تتناهى.
والجواب قلنا هذا الكلام غير
مستقيم وضعاً وتقسيماً أما الوضع فقولكم لو كان العالم محدثاً كان وجوده
متأخراً فإن عنيتم به التأخر بالزمان فغير مسلم فإنا قد بينا أن التقدم
والتأخر والمعية الزمانية تمتنع في حق الباري سبحانه.
وعلى هذا لم يصح
بنا التقسيم عليه أنه متأخر بمدة أو لا بمدة فإن ما لا يقبل المدة ذاتاً
ووجوداً لا يقال له تقدم أو تأخر أو قارن بمدة أو لا بمدة فأحلتم علينا
تقدماً وتأخراً ومعية زمانية للباري تعالى وإذا منعنا ذلك ألزمتم علينا
مقارنة في الوجود وذلك تلبيس فإنا إذا منعنا التقدم والتأخر الزماني منعنا
المقارنة الزمانية بل وجود الباري تعالى لا يقال متقدم بالزمان كما لا
يقال أيضاً فوق بالمكان ولا يقال مقارن بالزمان كما لا يقال مجاور للعالم
بالمكان وإن عنيتم بالتأخر في الوجود أي الموجِد مفيد الوجود والموجَد
مستفيد الوجود والموجِد لا أول لوجوده والموجَد له أول فهو مسلم ولا يصح
أيضاً بنا التقسيم عليه أنه تأخر بمدة أو لا بمدة.
فإن قيل لا بد من نسبة ما بين الموجِد والموجَد وإذا تحققت النسبة فبمدة
متناهية أو غير متناهية.
قلنا
ولا بد من نفي النسبة بين الموجِد والموجَد إذ لو تحققت النسبة بمدة
متناهية أو غير متناهية كان وجوده زمانياً قابلاً للتغير والحركة أليس لو
قال القائل ما نسبة واحد منا حيث حدث وله أول كان السؤال محالاً أليس لو
قال القايل ما نسبة العالم منه تعالى حيث وجد وله نهاية أفيباينه أو
يجاوره فإن باينه أفبخلا أو بينونة تتناهى أم لا تتناهى كان السؤال محالاً
كذلك نقول في المدة فإن الجزئي كالكلي والزمان كالمكان.
وجواب آخر
عن التقسيم نقول ما المعنى بالمدة أهي عبارة عن أمر موجود أو عن تقدير
موجود أم عن عدم بحت فإن كان أمراً موجوداً محققاً فهو من العالم فلا يكون
قبل العالم وأيضاً الموجود إما قايم بنفسه أو قايم بغيره وعلى الوجهين
جميعاً لا يمكن تقديره قبل العالم وإن كان أمراً مقدراً وجوده والتقديرات
الوهمية تجويزات وليس كلما يجوزه العقل أو يقدره الوهم يمكن وجوده جملة
حاصلة فإن وجود عالم آخر وكذلك إلى ما لا يتناهى مما يجوز يقدره الوهم
وكذلك الأعداد التي لا تتناهى مما يقدره الوهم لا مما يجوزه العقل
وبالجملة الجايزات كلها لا يمكن أن توجد جملة حاصلة فيكون ما لا يتناهى
مما يحصره الوجود وذاك محال فعلم أن تقدير أزمنة غير متناهية لا يكون
كالتحقيق وما يمكن وجوده جملةً معاً أو متعاقباً لا يمكن أن يكون مشحوناً
بما لا يتناهى وإن كانت المدة عبارة عن عدم بحت فلا يتناهى ولا لا يتناهى
في عدم البحت.
وجواب آخر لم قلتم أن المدة لو كانت متناهية لتناهى وجود
الباري تعالى فإن تناهي المدة كتناهي العالم مكاناً وهو مصادرة على
المطلوب الأول وتعبير عن محل النزاع ثم تناهي العالم مكاناً ليس يقتضي
تناهي ذات الباري تعالى لأنه لا مناسبة بينه وبين المكانيات والمكان كذلك
تناهي العالم زماناً لا يقتضي تناهي وجود الباري تعالى لأنه لا مناسبة
بينه وبين الزمانيات والزمان ولم قلتم أن المدة لو لم تكن متناهية في
التقدير العقلي أمكن أن يوجد فيها موجودات في التحقيق الحسي.
شبهة أخرى
قال ابن سينا حكاية عن أرسطاطاليس كل حادث عن عدم فإنه يسبقه إمكان الوجود
ضرورة وإمكان الوجود ليس هو عدماً محضاً بل هو أمر ما له صلاحية الوجود
والعدم ولن يتصور ذلك إلا في مادة فكل حادث فإنه يسبقه مادة ثم تلك المادة
المتقدمة لا تتصور إلا في زمان لأن قبل ومع لا يتحقق إلا في زمان والمعدوم
قبل هو المعدوم مع وليس الإمكان قبل هو الذي يقارن الوجود فهو إذاً متقدم
تقدماً زمانياً والعالم لو كان حادثاً عن عدم لتقدمه إمكان الوجود في مادة
تقدماً زمانياً فهو إما أن يتسلسل فهو باطل وإما أن يقف على حد لا يسبقه
إمكان فلا يسبقه عدم فيكون واجباً بغيره وهو ما ذهبنا إليه وهذه الشبهة هي
التي أوقعت المعتزلة في اعتقاد كون المعدوم شيئاً وعن هذا قصروا الشيئية
في الممكن وجوده لا المستحيل ثبوته.
والجواب أنا قد بينا أن معنى
الحدوث عن عدم أنه هو الموجود الذي له أول لا الإمكان السابق عليه ليس
يرجع إلى ذات وهو شيء حتى يحتاج إلى مادة بل هو أمر راجع إلى التقدير
الذهني لأن ما لا يجوز وجوده لا يتحقق له ثبوت وحدوث والقبلية والمعية
راجعة أيضاً إلى التقدير العقلي وإنما نتصور نحن من حدوث العالم ما
يتصورونه من حدوث النفس الإنسانية حادثة لها أول لا عن شيء حتى يمكن أن
يقال أنها مسبوقة بالعدم أي لم تكن فكانت وهي ممكنة الوجود في ذاتها
وإمكانها لا يستدعي مادة تسبقها فإن ذلك يودي إلى أن يكون وجودها مادياً
فعلم أن الإمكان من حيث هو إمكان ليس يستدعي مادة وسبقه على الموجود
الحادث ليس إلا سبقاً في الذهن سميتموه سبقاً ذاتياً وذلك السبق ليس سبقاً
زمانياً وكذلك القول في المعلول الأول وساير النفوس فإنها ممكنة الوجود
بذواتها وإمكان وجودها سابق على وجودها سبقاً ذاتياً وكذلك القول في الجسم
الأول الذي هو فلك الأفلاك ونقول أن كل حادث حدوثاً زمانياً أو حدوثاً
ذاتياً على أصلكم فإنه يسبقه إمكان الوجود فإن الموجود المحدث قد تردد بين
طرفي الوجود والعدم وهذا التردد والسبق والإمكان كله يرجع إلى تقدير في
الذهن وإلا فالشيء في ذاته على صفة واحدة من الوجود لكن الوجود باعتبار
ذاته انقسم إلى ما يكون وجوده لوجود هو له لذاته أي هو غير مستفاد له من
غيره فيقال الوجود أولى به وأول ما يكون وجوده لوجود هو له من غيره فيقال
الوجود ليس أولى به ولا أول وهذا الوجود لم يتحقق إلا أن يكون له أول
مسبوق بوجود لا أول له ويكون له في ذاته إمكان الوجود يعبر عنه بأنه مسبوق
بإمكان الوجود لا أنه وجود يسبقه إمكان الوجود بل الوجود في ذاته وجود
ممكن فقد وجد ها هنا سبقان أحدهما سبق وجود الموجود والثاني سبق إمكان
الوجود ولكننا بعدما بحثنا عن السبق الثاني لم نعثر على معنى إلا أن
الوجود المستفاد لن يتحقق إلا بأن يكون ممكناً في ذاته مقدراً فيه تردد
بين طرفي الوجود والعدم واحتاج إلى مرجح لولاه لما حصل له وجود فلو كان كل
حادث محتاجاً إلى سبق إمكان وكل إمكان محتاجاً إلى مادة وكل مادة إلى زمان
تسلسل القول فيه فيقال وتلك المادة والزمان يحتاجان إلى مادة وزمان ولما
حصل وجود حادث أصلاً فبطل الأصل الذي وضعوا الكلام عليه بل لا بد من منتهى
ينتهي إليه فيكون مبدعاً لا من شيء ويكون ممكناً في ذاته ولا يستدعي
إمكانه مادةً وزماناً فهكذا يجب أن يتصور معنى سبق الإمكان وسبق العدم
وسبق الموجد فإن الموجِد يسبق بوجوده من حيث وجوده ويلزم ذلك أن يسبق
العدم والإمكان في الموجد سبقاً تقديرياً وقد تقرر الفرق بين التقدم
الذاتي والتقدم الوجودي فتأمل ذلك.
شبهة أخرى اعتمد عليها أبو علي بن
سينا قال أسلم أن العالم بما فيه من الجواهر والأعراض جايز الوجود لذاته
لكن كلامنا في أنه هل هو واجب الوجود بغيره دايم الوجود بدوامه قال
والجايز أن لا يوجد وأن يوجد وإذا تخصص بالوجود احتاج إلى مرجح لجانب
الوجود والحال لا يخلو إما أن يقال ما يجوز أن يوجد عن المرجح يجب أن يوجد
حتى لا يتراخى عنه وإما أن يقال لا يجب أن يوجد حتى يتراخى عنه ثم يوجد
بعد أن لم يوجد لكن العقل الصريح الذي لم يكذب يقضي أن الذات الواحدة إذا
كانت من جميع جهاتها واحدة وهي كما كانت وكان لا يوجد عنها شيء فيما قبل
مع جواز أن يوجد وهي الآن كذلك فالآن لا يوجد عنها شيء وإذا كان قد وجد
فقد حدث أمر لا محالة عن قصد وإرادة وطبع وقدرة أو تمكن وغرض أو سبب من
الأسباب ثم لا يخلو ذلك السبب إما أن يحدث في ذاته صفة أو يحدث أمراً
مبايناً عنه والكلام في ذلك الحادث على أي وجه كان كالكلام في العالم
فإذاً لا يجوز أن يحدث أمر ما وإذا لم يجز فلا فرق بين حال أن يفعل وبين
حال أن لا يفعل وقد وجد الفعل فهو خلف وإنما ألزمنا هذا لأنا وضعنا في
التقدير العقلي ذاتاً معطلة عن الفعل وهو باطل فنقيضه حق.
والجواب قلنا
أنتم مطالبون بإثبات ثلث مقدمات إحداها إثبات جواز وجود العالم في الأزل
والثانية إثبات أن ما يجوز وجوده يجب وجوده والثالثة إثبات سبب حادث لأمر
حادث.
أما الأولى فنحن قد بينا استحالة وجود أمر جايز في ذاته مع
وجود موجود واجب في ذاته في الأزل من وجهين أحدهما استحالة اقتران وجود ما
لا أول له مع وجود ما له أول فإن الجمع بينهما من المحالات والوجود الواجب
لذاته يجب أن يتقدم الوجود الجايز لذاته تقدماً ما في وجوده بحيث يكون
الواجب موجوداً ولا وجود معه لا من حيث الوجود ولا من حيث الذات ولا من
حيث الزمان ولا من حيث الرتبة والمكان ولا من حيث الفضيلة وبالجملة فحيث
ما تحقق الجواز والإمكان في شيء تحقق نفي الأزلية عنه وإثبات الأولية له
واقتران الأزلية والأولية في شيء واحد محال وقولكم العالم جايز الوجود وكل
جايز وجوده يجب وجوده أزلاً وأبداً جمع بين قضيتين متناقضتين ومن اعترف
بالجواز والإمكان فقد سلم المسئلة من كل وجه فإن الشيء إذا تطرق إليه
الجواز في الوجود من وجه تطرق إليه الجواز من ساير الوجوه أعني الوقت
والمقدار والشكل إذا كان الموجود قابلاً لها أو لواحد منها والداير بين
وجوه الجواز إذا تخصص بأحد الجايزين دون الثاني احتاج إلى مخصص وانتفى
الوجوب والدوام عنه.
وأما الوجه الثاني في بيان الاستحالة أن الحوادث التي لا تتناهى قد تبين
استحالتها.
فإن قيل ما المانع من وجود العالم في الأزل كان الجواب استحالة حوادث لا
تتناهى لما بينا من البرهان الدال عليه.
وأما الكلام على المقدمة الثانية وهي أن ما يجوز وجوده يجب وجوده.
قلنا
هذا الكلام أولاً متناقض لفظاً ومعنى أما اللفظ فإن الجواز والوجوب
متناقضان إلا أن يقال أن ما يجوز وجوده في ذاته يجب وجوده بغيره قيل وهذا
أيضاً باطل فإن الوجوب بالغير إنما يكون بإيجاب الغير والجايز إنما يحتاج
إلى الواجب في وجوده لا في وجوبه فيكون وجوده بايجاد الغير ثم يلزمه من
حيث النسبة وجوبه وقد تبين هذا المعنى فيما قبل وأما التناقض من حيث
المعنى فهو أن الجايز وجوده مما لا يتناهى فلو كان ما جاز وجوده وجب وجوده
لوجد ما لا يتناهى دفعةً واحدة وإذا شرط الترتيب في الذوات حتى حصل في
الوجود أول ثم ثان ثم ثالث ثم ينتهي إلى موجودات محصورة كذلك يشترط
الترتيب في الموجود حتى حصل موجود له أول ثم ثان ثم ثالث فالترتيب في
الذوات تقدماً وتأخراً كالترتيب في الموجودات أولاً وآخراً وهذا بناء على
ما ذكرناه من إثبات قسم آخر في أقسام التقدم والتأخر وذلك واجب الرعاية.
وأما
الكلام في المقدمة الثالثة وهي المغلطة الزباء والداهية الدهيا وكثيراً ما
كنا نراجع أستاذنا وإمامنا ناصر السنة صاحب الغنية وشرح الإرشاد أبا
القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري فيها ويتكلم عليها فما يزيد فيها على أن
إثبات وجه فاعلية الباري سبحانه وتعالى مما يقصر عن دركه عقول العقلا ثم
الذي كان يستقر كلامه عليه إن قال ثبت جواز وجود العالم عقلاً وثبت حدوثه
دليلاً ويعرف أن ما حدث بذاته فيجب نسبة حدوثه إلى واجب الوجود بذاته
والخصم إنما يطالب بوجه النسبة فإن الموجد إذا كان لا يوجد وأوجد فنسبة
الحادث إليه قبل الإيجاد كنسبته إليه حال الإيجاد وبعده ولم يحدث أمر ما
ولا سبب فلم وجد ولم أوجد وبالجملة فما معنى الإيجاد والإبداع إن قلت انه
علم وجوده في هذا الوقت وأراد وجوده فيه قيل العلم عام التعلق والإرادة
عامة التعلق فنسبة وجوده إلى الإرادة العامة في هذا الوقت على هذا الشكل
كنسبة وجوده في غير هذا الوقت على غير هذا الشكل وكذلك القول في القدرة
فإنها في عموم تعلقها كالإرادة والعلم فلا خصوص في الصفات فكيف يختص الفعل
وهذا الموضع منشأ ضلال بعض المتكلمين فإن الكرامية أثبتوا حوادث في ذات
الباري تعالى من الإرادة والقول وهي التي تخصص العالم بالوجود دون العدم
والمشية القديمة تتعلق عندهم تعلقاً عاماً والإرادة تعلق تعلقاً خاصاً
وفرقوا بين الأحداث والمحدث والخلق والمخلوق والمعتزلة أثبتوا إرادات
حادثة لا في محل هي التي تخصص العالم بالوجود دون العدم ولم يفرقوا بين
الأحداث والمحدث والخلق والمخلوق والأولى أن نسلك في حل الإشكال طريق
إبطال مذهب الخصم ثم نشير إلى ما يلوح للعقل من معنى الإيجاد.
فنقول
اتفقنا على أن العالم جايز لذاته محتاج إلى مرجح لجانب الوجود على العدم
فالمرجح لا يخلو إما أن يرجح من حيث هو ذات أو من حيث هو وجود ويلزم عليه
أمران أحدهما أن يكون كل ذات وكل وجود مرجحاً والثاني أن يحدث ما يجوز
وجوده مما لا يتناهى فان نسبة الجميع إلى الذات والوجود نسبة واجدة
والوجهان محالان وإما أن يرجح من حيث هو ذات أو وجود على صفة أو على
اعتبار ووجه فان يرجح من حيث هو وجود على صفة فقد سلمت المسئلة وبطل
الايجاب الذاتي وإن يرجح من حيث هو وجود على وجه كما قال الخصم أنه واجب
الوجود لذاته وإنما أوجب من حيث أنه واجب لذاته وهو وجود على وجه فهو
أيضاً باطل فإن وجوب الوجود لذاته معناه أمر سلبي أي وجوده غير مستفاد من
غيره ومن فهم وجوداً غير مستفاد لم يلزمه أن يفهم أنه مفيد غيره وكذلك من
فهم أنه عالم أو عقل وعاقل كما قال الخصم لم يلزم منه أن يفهم منه أنه
موجد مفيد الوجود غيره لأن معنى كونه عقلاً عند الخصم معنى سلبي أيضاً أي
مجرد عن المادة وبأن يكون مجرداً عن المادة لا يلزم أن يكون مفيد الوجود
لغيره فبطل الإيجاب الذاتي من كل وجه وتعين أنه إنما أوجد لكونه على صفة
ولتلك الصفة من حيث ذاتها صلاحية التخصيص والإيجاد عموماً بالنسبة إلى ما
حصل على الهيئة التي حصل وبالنسبة إلى غيرها نسبة واحدة ولها أيضاً خصوص
وجه بالنسبة إلى ما حصل دون ما لم يحصل وذلك الخصوص لها عند إضافتها إياها
إلى غيرها.
فنقول لما علم الباري وجود العالم في الوقت الذي وجد فيه
أراد وجوده في ذلك الوقت فالعلم عام التعلق بمعنى أنه صفة صالحة لأن يعلم
به جميع ما يصح أن يعلم والمعلومات لا تتناهى على معنى أنه علم وجود
العالم وعلم جواز وجوده قبل وبعد على كل وجه يتطرق إليه الجواز العقلي
والإرادة عامة التعلق بمعنى أنها صفة صالحة لتخصيص ما يجوز أن يخصص به
والمرادات لا تتناهى على معنى أن وجوه الجواز في التخصيصات غير متناهية
ولها خصوص تعلق من حيث أنها توجد وتوقع ما علم وأراد وجوده فإن خلاف
المعلوم محال وقوعه فالصفات كلها عامة التعلق من حيث صلاحية وجودها
وذواتها بالنسبة إلى متعلقاتها إلى ما لا يتناهى خاصة التعلق من حيث نسبة
بعضها إلى بعض والإرادة لا تخصص بالوجود إلا حقيقة ما علم وجوده والقدرة
لا توقع إلا ما أراد وقوعه وتعلقات هذه الصفات إذا توافقت على الوجه الذي
ذكرناه حصل الوجود لا محالة من غير تغيير يحصل في الموجِد وإنما يتعذر
تصور هذا المعنى علينا لأنا لم نحس من أنفسنا إيجاداً وإبداعاً ولا كانت
صفاتنا عامة التعلق فعلمنا إذاً لم يتعلق إلا بمعلوم واحد ولم تتعلق
إرادتنا إلا بمراد واحد ولا قدرتنا إلا بمقدور واحد لا على سبيل الإيجاد
ولن يتصور بقا صفاتنا لكونها إعراضاً فيتقاضى عقلنا وحسنا حدوث سبب لحدوث
أمر حتى لو قدرنا علماً وإرادةً وقدرةً لها عموم التعلق بمتعلقات لا
تتناهى على معنى صلاحية كل صفة لمتعلقها وقدرنا صلاحية قدرتنا للإيجاد
وقدرنا بقا الصفات فعلمنا وجود شيء بقدرتنا وإراداتنا في وقت مخصوص ودخل
الوقت لا نشك أن الشيء يقع ضرورة من غير أن تتغير ذاتنا أو يحدث أمر أو
سبب لم يكن وهذا كما يقدره الخصم في العقل الفعال وفيضه فإنه يقول هو عام
الإفاضة واهب للصور على الإشاعة من غير تخصيص ثم يثبت له نوع خصوص
بالإضافة إلى القوابل والشرايط التي تتكون فتحصل استعداداً في القوابل
فيختص الفيض بقابل مخصوص على قدر مخصوص فخصوص الفيض بسبب خارج عن ذات
المفيض لا يقدح في عموم الفيض باعتبار ذاته على أن الإيجاب الذاتي عند
الخصم فيض ذاتي هو وجود عام لا خصوص فيه ولكنه إنما يفيض منه واحد ثم من
الواحد يفيض عقل ونفس وفلك ومن كل عقل ونفس عقل ونفس حتى ينتهي بالعقل
الأخير ثم يفيض منه الصور على الموجودات السفلية وتنتهي بالنفس الناطقة.
فنقول
ما الموجب لحصر الموجودات في هذه الذوات ولا خصوص في الفيض وإن تناهي
الموجودات عدداً ومكاناً كتناهي الموجودات بدايةً وزماناً.
فإن قلتم أن الخصوص عندنا يرجع إلى قبول الحوامل فيقدر الفيض بمقدارها.
قيل
وكلامنا في أصل الحوامل لم انحصر في عدد معلوم فلم انحصرت السماوات في سبع
أو تسع ولم انحصرت العناصر في أربعة ولم انحصرت المركبات في عدد معلوم ولم
تناهت هذه الموجودات فهلا ذهبت السموات إلى غير نهاية مكاناً كما ذهبت
حركاتها إلى غير نهاية زماناً.
فإن قلتم منعنا من ذلك برهان عقلي على
أن العالم متناه مكاناً قلنا ومنعنا عن ذلك أيضاً ذلك البرهان بعينه كما
بينا وكل ما ذكرتموه في العناية الإلهية التي أوجبت ترتيب الموجودات على
نظامها الأكمل نقدره نحن في الإرادة الأزلية التي اقتضت تخصيص الموجودات
على النظام الذي علمه أو ليس لم يكف على أصلكم مجرد وجود مطلق حتى خصصتم
بالوجوب ولم يكف الوجوب حتى خصصتم بالتعقل ولم يكف التعقل حتى خصصتم
بالعناية ثم عدتم فقلتم هذه صفات إضافية أو سلبية لا توجب تكثراً في ذاته
وتغيراً فما سميتموه تعقلاً نحن نقول هو علم أزلي وما سميتموه عناية نحن
نقول هو إرادة أزلية فكما أن العناية عندكم ترتبت على العلم فعندنا
الإرادة إنما تتعلق بالمراد على وفق العلم فلا فرق بين الطريقين إلا أنهم
ردوا معاني الصفات إلى الذات وعند المتكلمين معاني الصفات لا ترجع إلى
الذات فالأولى بالمناظرة في هذه المسئلة أن يدفع الخصم إلى تعيين محل
النزاع وتبيين مذهبه فيستفيد بذلك بطلان مذهب الخصم فإن يقول أول ما صدر
عن الباري تعالى فهو العقل الأول لأنه لا يصدر عن الواحد إلا واحد ثم
العقل أوجب عقلاً آخر ونفساً وجسماً هو فلك الأفلاك وبتوسط كل عقل عقلاً
ونفساً وفلكاً حتى انتهت الأفلاك بالفلك الأخير الذي يديره العقل الفعال
الذي هو واهب الصور في العالم وبتوسط العقول السماوية والحركات الفلكية
حدثت العناصر وبتوسطها حدثت المركبات وآخر الموجودات هي النفس الإنسانية
لأن الوجود ابتدأ من الأشرف فالأشرف حتى بلغ إلى الأخس وهو الهيولي ثم
ابتدأ من الأخس فالأخس حتى بلغ الأشرف فالأشرف وهو النفس الناطقة
الإنسانية.
فيقال لهم هذه الموجودات السفلية على هيئتها وأشكالها من
أنواعها وأصنافها التي تراها أوجدت دفعة واحدة أم على ترتيب فإن وجدت دفعة
واحدة بطل الترتيب الذي أوجده في وجود الموجودات وإن حصلت على ترتيب شيئاً
بعد شيء فأنى تحقق سبق ذاتي وتأخر ذاتي بين المعلول الأول والمعلول الأخير.
ونقول
ما نسبة المعلول الأخير إلى المعلول الأول من حيث الزمان وهما وإن كانا في
ذواتهما غير زمانيين إلا أن النفس الإنسانية حدثت حدوثاً لم تكن قبل ذلك
موجودة فتحقق لها أول فما نسبة أولية النفس إلى العقل الأول فإن كان
بينهما نفوس غير متناهية حدثت في أزمنة غير متناهية كان غير المتناهي
محصوراً بين حاصرين وذلك محال وإن كانت متناهية فبطل قولهم أن الحوادث لا
تتناهى إذ لو كانت الحركات السماوية غير متناهية كانت الموجودات السفلية
غير متناهية أيضاً وحصل من نفس بيان المذهب بطلانه ثم هم منازعون في
الترتيب الذي ذكروه فإن أصحابهم قد اختلفوا في المبادي اختلافاً ظاهراً
فمنهم من قال أول الموجودات هو العنصر ثم العقل ثم النفس ثم الجسم ومنهم
من قال العقل ثم النفس ثم الهيولي ثم الأفلاك ثم العناصر ثم المركبات كما
سيأتي بيان ذلك.
شبهة من شبه برقلس قال الباري سبحانه جواد بذاته وعلة
وجود العالم جوده وجوده قديم لم يزل فيلزم أن يكون وجود العالم قديماً لم
يزل قال ولا يجوز أن يكون مرة جواداً ومرة غير جواد فإنه يوجب التغير في
ذاته قال ولا مانع من فيض جوده إذ لو كان مانع لما كان من ذاته إذ المانع
الذاتي مانع أبداً وقد تحقق الجود بإيجاد الموجود فهو خلف ولو كان المانع
من غيره كان الغير هو الحامل لواجب الوجود وواجب الوجود لا يحمل على شيء
ولا يمنع من شيء.
شبهة أخرى تقارب هذه الشبهة قال ليس يخلو الصانع من
أن يكون لم يزل صانعاً بالفعل أو لم يزل صانعاً بالقوة فإن كان الأول
فالمصنوع معلول لم يزل وإن كان الثاني فما بالقوة لا يخرج إلى الفعل إلا
بمخرج ومخرج الشيء من القوة إلى الفعل غير ذات الشيء فيجب أن تتغير ذات
الصانع لمغير وذلك باطل.
شبهة أخرى قال كل علة لا يجوز عليها التحرك
والاستحالة فإنما تكون علة من جهة ذاتها لا من جهة الانتقال من غيرها وكل
علة من جهة ذاتها فمعلولها من جهة ذاتها وإذا كانت ذاتاً لم تزل فمعلولها
لم يزل.
والجواب قلنا ما المعنى بقولك الباري تعالى جواد بذاته وما
معنى الجود فإن عندنا وعندكم الجود ليس صفة ذاتية زايدة على الذات بل هو
صفة فعلية والصفات عندكم إما أن تكون سلوباً كالقديم والغنى فإن معنى
القديم نفي الأولية ومعنى الغنى نفي الحاجة وأما أن تكون إضافات كالخالق
والرازق على اصطلاحنا والمبدئ والعلة الأولى على اصطلاحكم وليس لله صفة
وراء هذين المعنيين فالجود من قسم الإضافة لا من قسم السلب فلا فرق إذاً
بين معنى المبدئ وبين معنى الجود ومعناهما الفاعل الصانع فكأنكم قلتم صانع
بذاته وهو محل النزاع ومصادرة على المطلوب الأول فإن الخصم يقول ليس
فاعلاً لذاته وفعله ليس قديماً لم يزل وفيه وقع الخلاف غيرت العبارة من
الفعل إلى الجود وجعلته دليل المسئلة وإذا كان معنى الجود راجع إلى الفعل
والإيجاد فقوله مرة هو جواد ومرة غير جواد كقوله مرة فاعل ومرة غير فاعل
وذلك أيضاً محل النزاع فلم يجب أن يقال انه يوجب التغير.
وإنما حل
الشبهة فيه من وجهين أحدهما أن الفعل إنما امتنع في الأزل لا لمعنى يرجع
إلى الفاعل بل لمعنى راجع إلى نفس الفعل حيث لم يتصور وجوده فإن الفعل ما
له أول والأزل ما لا أول له واجتماع ما لا أول له مع ما له أول محال فهو
تعالى جواد حيث يتصور الجود ولا يستحيل الموجود أليس لو عين الشخص في
زماننا فيقال يجب أن يوجد أزلاً لأن الباري سبحانه جواد لذاته كان السؤال
محالاً لأن الموجود المعين استحال وجوده فيما لم يزل فاستحالة وجود
الموجود هو المانع لفيض الوجود لا منعاً يكون ذلك حملاً أو زجراً بل هو
ممتنع في ذاته وهكذا لو أوجد ما أوجده أولاً أو أوجد جميع الموجودات معاً
من غير ترتيب واحد على واحد كل ذلك غير جايز عند الخصم ولم يقدح في كونه
جواداً هذا كما يقدره المتكلم أن الباري سبحانه يوصف بالقدرة على ما يجوز
وجوده وإما ما يستحيل وجوده فلا يقال الباري تعالى ليس قادراً عليه بل
يقال المستحيل في ذاته غير مقدور فلا يتصور وجوده.
وهذا هو الجواب أيضاً عن قولهم لو لم يكن صانعاً فصار صانعاً كان صانعاً
بالقوة فصار صانعاً بالفعل وتغيرت ذاته.
فإنا
نقول إنما لم يكن صانعاً لم يزل لأن الصنع فيما لم يزل مستحيل الوجود وإذا
استحال وجود الشيء في نفسه ولذاته لم يكن مقدوراً فلا يكون مصنوعاً قط
وإذا استحال وجود الشيء لمعنى آخر كان جايزاً في ذاته فإذا زال ذلك المعنى
تحقق الجواز فصار مقدوراً فيكون مصنوعاً والصنع لم يزل إنما استحال لنفي
أولية الأزل وإثبات أولية الصنع فكان الجمع بينهما محالاً فإذا نفيت
الأزلية تعينت الأولية فتحقق الجواز فصح المقدور فوجد المصنوع.
وكذلك
الجواب عن الشبهة الثالثة أنه علة لذاته فإن معنى كونه علة أي مبدئ لوجود
شيء وإنما الممتنع وجود المعلول مع العلة معية بالذات فإن ذلك يرفع العلية
والمعلولية وكذلك نقول يستحيل وجود المعلول مع العلية معية بالزمان فإن
ذلك يوجب كون العلة زمانية قابلة للتغير وذلك محال أيضاً فيجب أن يتقدم في
الوجود لأن وجود الباري سبحانه وجود لذاته غير مستفاد من غيره ووجود
العالم مستفاد منه والمفيد أبداً يتقدم في الوجود.
أما الوجه الثاني في
حل الشبهة أن نطالبهم أولاً فنقول بما عرفتم أنه سبحانه يجب أن يكون
جواداً لذاته قالوا لأن موجوداً ما يفعل أكمل من موجود لا يفعل وإن تصدر
عنه موجودات أشرف من أن لا تصدر.
قيل له لو عكس الأمر عليكم أن الموجود
الذي لا يفعل أكمل فما جوابكم عنه إذ ليس هذا من القضايا الضرورية خصوصاً
في موجود يكون كماله بذاته لا بغيره وإنما يصدر عنه فعل لو صدر لا لغرض
ولا ليكتسب به حمداً ولا أمراً ما يتعلق بالتناقل لعمري لو كان موجودان
أحدهما كماله بذاته والآخر كماله من غيره شهد العقل بالضرورة أن الذي
كماله بالذات أشرف من الذي كماله بغيره والموجود الذي لو لم يفعل فعلاً
كان ناقصاً فليس بكامل الذات بل هو ناقص مستكمل من غيره فلم يصح أن يكون
واجب الوجود لذاته.
وأما حل الشبهة الثانية نقول ما المعنى بقولكم إذا
لم يكن صانعاً فصار صانعاً فقد تجدد أمر فنقول تجدد في ذات الصانع أمر أم
تجدد أمر في غير ذاته والأول غير مسلم والثاني مسلم وهو محل النزاع.
وقولهم
كان صانعاً بالقوة أيضاً مشترك فإن القوة يراد بها الاستعداد المجرد ويراد
بها القدرة والأول غير مسلم والثاني مسلم وهو محل النزاع ولا يحتاج إلى
مخرج إلى الفعل.
وأما حل الشبهة الثالثة قال كل علة لا يجوز عليها
التحرك والاستحالة فإنما تكون علة من جهة ذاتها غير مسلم بل هو باطل على
أصله بالعقل الأول فإنه لا يجوز عليه التحرك والاستحالة وليس علة من جهة
ذاته بل هو معلول الواجب الوجود وعلة من جهة كونه واجباً به لا بذاته
وكذلك العقول المفارقة لا تقبل الحركة والاستحالة وليست عللاً من جهة
ذواتها.
ومما يعتمد في إثبات حدث العالم أن نفرض الكلام في النفوس
الإنسانية ونثبت تناهيها عدداً ثم ترتب عليها تناهي الأشخاص الإنسانية
وترتب عليها حدوث الأمزجة وتناهيها ثم نرتب عليها تناهي الحركات الدورية
الجامعة للعناصر ثم ترتب عليها تناهي المتحركات والمحركات السماوية فثبت
حدث العالم بأسره وهي أسهل الطرق وأحسنها.
فنقول قد تقرر في أوايل
العقول إن كل عدد أو معدود موجود بالفعل إذا كان غير متناه بالفعل فإنه لا
يقبل الزيادة والنقصان وإن الزايد لا يكون مثل الناقص قط ولا يمكن أن يكون
شيء أكبر من مقدار غير متناه لموجود وجد وغير المتناهي لا يتضاعف بما لا
يتناهى وإن ما يتناهى من طرف يتناهى من سائر الأطراف والنفوس الإنسانية
عند القوم موجودات بالفعل مجتمعة في الوجود وهي قابلة للزيادة والنقصان
فإن الزمان الذي نحن فيه قد اشتمل على أشخاص إنسانية متناهية ولكل شخص نفس
إذا أضفت تلك النفوس إلى ما مضى من الأشخاص التي بقيت نفوسها كانت الأوائل
منها أنقص وهي مع الزيادة أزيد وكذلك في كل زمان وساعة تتزايد النفوس
أبداً وما قبل الزيادة في كل وقت يستحيل أن يكون غير متناه وذلك لأن نسبة
ما مضى إلى الحاصل كنسبة الناقص إلى الزايد وحيث ما تمادى إلى الأول صار
أنقص كما إذا تمادى إلى الآخر صار أزيد ومثل هذا مستحيل فيما لا يتناهى
موجوداً بالفعل محصوراً في الوجود نعم ربما يظن في الموجودات المتعاقبة في
الوجود أنها لا تتناهى قبل آخر وآخراً بعد أول وأنها إذا جازت غير متناهية
آخراً جازت غير متناهية أولاً وهذا الظن وإن كان خطأ عند العقل إلا أن
الخيال ربما يعين هذا الرأي لكن الفرض إذا كان في موجودات غير متناهية
مجتمعة في الوجود لا متعاقبة أعداداً ومعدودات بالفعل لا بالقوة فيلزمها
ضرورة ألا تقبل الزيادة والنقصان إذ لو قبلت وهي غير متناهية لكان الزايد
مثل الناقص.
والذي يوضحه أن كل جملة موجودة الآحاد بالفعل إذا زيد عليها عدد معلوم أو
نقص منها عدد محصور صار ما لا يتناهى أكثر مما كان أو أنقص.
فنقول
إذا دخل ما لا يتناهى في الوجود من النفوس فالباقي من النفوس التي لم تدخل
في الوجود بعد أما إن كانت متناهية أو غير متناهية فإن لم تكن متناهية فقد
تضاعف ما لا يتناهى بما لا يتناهى وذلك محال وإذا كانت متناهية فإذا زيدت
على غير المتناهي صارت الجملة أكثر من المقدار الأول وقد علم أن غير
المتناهي الموجود لا يكون شيء أكثر منه وهذا أكثر منه فهو خلف ثم يلزم أن
يكون الباقي على نسبة عددية إذ هي موجودة بالفعل أما نسبة النصف أو الثلث
أو الربع أو غير ذلك من النسب وإذا كانت الجملة غير متناهية بالفعل استحال
تقدير النسبة إليها فإن ما لا يتناهى لا نصف له ولا ثلث ولا ربع وإذا
تحققت النسبة دل ذلك على أن الجملة محصورة معدودة متناهية وليس يلزم على
ما ذكرناه كون العدد غير متناه فإنا لا نسلم ذلك في عدد معلوم موجود ومعنى
قولنا أن العدد لا يتناهى انه في التقدير الوهمي لا يتناهى أي الوهم يعجز
عن بلوغ حد ونهاية فيه فيحكم العقل انه لا نهاية له وكما أن العدد على
الإطلاق معلوم من غير ربط بمعدود وكذلك النصف والثلث والربع على الإطلاق
معلوم من غير نسبة إلى ما لا يتناهى إنما المستحيل إثبات أعداد موجودة غير
متناهية فإن كل موجود معدود فهو محدود وإذا تحقق بطلان النفوس الغير
متناهية وكانت كل نفس متعلقة ببدن تحقق بطلان الأبدان الغير متناهية ثم
إذا تناهت الأبدان والنفوس الإنسانية تناهت الامتزاجات العنصرية فتناهت
الحركات الدورية السماوية فتناهت المتحركات العلوية فتناهت المحركات
الروحانية فتناهى العالم بأسره فكان له أول منه ابتداء فأما تقدير عدم
عليه يمكن أن يكون قبله فهو تقدير خيالي كتقدير خلا وراء العالم يمكن أن
يكون فيه فالخلا بالنسبة إلى العالم مكاناً كالعدم بالنسبة إليه زماناً
وتقدير بينونة وراء العالم غير متناهية كتقدير أزمنة قبل العالم غير
متناهية.
ولو سأل سائل هل يمكن تقدير عالم آخر وراء هذا العالم ووراء
ذلك العالم عالم آخر إلى ما لا يتناهى كان السؤال محالاً كذلك لو سأل هذا
هل يمكن تقدير هذا العالم أو عالم آخر قبله بزمان وقبل ذلك القبل بزمان
إلى ما لا يتناهى كان السؤال أيضاً محالاً فليس قبل العالم إلا موجده
ومبدعه قبلية الإيجاد والإبداع لا قبلية الإيجاب بالذات ولا قبلية الزمان
كما ليس فوق العالم إلا مبدعه فوقية الإبداع والتصرف لا فوقية الذات ولا
فوقية المكان والله المستعان.
القاعدة الثانية
في حدوث الكائنات بأسرها بأحداث له سبحانه
وفيها الرد على المعتزلة والثنوية والطبايعيين والفلاسفة وفيها تحقيق الكسب والفرق بينه وبين الإيجاد والخلق مذهب أهل الحق من أهل الملل وأهل الإسلام أن الموجد لجميع الكائنات هو الله سبحانه فلا موجد ولا خالق إلا هو والفلاسفة جوزوا صدور موجود من غير الله تعالى بشرط أن يكون وجود ذلك الغير مستنداً إلى وجود آخر ينتهي إلى واجب الوجود بذاته ثم هم مختلفون في انه هل يجوز أن يصدر عنه أكثر من واحد فذهب أكثرهم إلى انه واحد من كل وجه فلا يصدر عنه إلا واحد.ثم اختلفوا في ذلك الواحد فقال بعضهم هو العقل وقال بعضهم هو العنصر ثم العقل واختلفوا في الصادر عن المعلول الأول فقال بعضهم هو النفس وقال بعضهم هو عقل آخر ونفس وفلك هو جسم وكذلك يصدر عن كل عقل عقل حتى انتهى بالعقل الذي هو مدير فلك القمر الفعال الواهب للصور على مركبات العالم ومن قدماء الأوائل من جوز صدور شيء متكثر من واجب الوجود واختلفوا فيه فمنهم من قال هو الماء ومنهم من قال هو النار ومنهم من قال هو الهواء ومنهم من قال هو أجسام لطيفة بسيطة تركبت أو أجزاء صغار اجتمعت فحدث العالم ومنهم من قال هو العدد ومنهم من قال هو المحبة والغلبة على ما قررنا تفصيل مذاهبهم في الإرشاد إلى عقائد العباد.
وأما المجوس فلهم تفصيل مذهب في حدوث الكائنات وسبب امتزاج النور والظلمة وسبب الخلاص لكن اتفقوا على نسبة الخير والصلاح إلى النور ونسبة الشر والفساد إلى الظلمة.
وأما
المعتزلة القدرية فأثبتوا للقدرة الحادثة تأثيراً في الإيجاد والأحداث من
الحركات والسكنات وبعض الاعتقادات والاعتمادات والنظر والاستدلال والعلم
الحاصل به وبعض الادراكات وهي التي يجد الإنسان من نفسه أنها تتوقف على
البواعث والدواعي وورود التكليف بمباشرتها والكف عنها.
ووافقنا الفلاسفة على أن جسماً ما أو قوة في جسم لا يصلح أن يكون مبدعاً
لجسم.
ووافقنا المجوس على أن الظلمة لا يجوز أن تحدث بإحداث النور.
ووافقنا
المعتزلة على أن القدرة الحادثة لا تصلح لأحداث الأجسام والألوان والطعوم
والروائح وبعض الإدراكات والحيوة والموت ولهم اختلاف مذهب في المتولدات
وإنما أوردنا هذه المسئلة عقيب حدث العالم لأن الدليل لما قام على أن
الممكن بذاته من حيث إمكانه استند إلى الموجد وإن الإيجاد عبارة عن إفادة
الوجود فكل موجود ممكن مستند إلى إيجاد الباري سبحانه من حيث وجوده
والوسايط معدات لا موجبات وهذا هو مدار المسئلة.
ولنا في تقرير هذا
المعنى كلام مع الفلاسفة على مقتضى قواعدهم ومع المجوس على موجب أصلهم
باعتبار انه موجود ومع المعتزلة على موجب عقائدهم.
أما الكلام على
الفلاسفة فنقول كل موجود بغيره ممكن باعتبار ذاته لو جاز أن يوجد شيئاً
فأما أن يوجده باعتبار انه موجود بغيره أو باعتبار انه ممكن بذاته أو
باعتبارهما جميعاً لكن لا يجوز أن يوجد باعتبار انه موجود بغيره إلا بشركة
من ذاته إذ لا تعزب ذاته عن ذاته ولا يخرج وجوده عن حقيقته وهو باعتبار
ذاته ممكن الوجود والإمكان طبيعته عدمية فلو أثر في الوجود لأثر بشركة
العدم وهو محال.
وهذا البرهان إنما نقلناه عن قولهم في الجسم انه لا
يؤثر في الجسم إيجاداً وإبداعاً إذ الجسم مركب من مادة وصورة فلو أثر
بشركة من المادة والمادة لها طبيعة عدمية فلا يجوز أن توجد شيئاً فالجسم
لا يجوز أن يوجد أيضاً فإمكان الوجود كالمادة ونفس الوجود كالصورة كما أن
الجسم لا يؤثر من حيث صورته إلا بشركة من المادة كذلك الموجود بغيره
الممكن باعتبار ذاته لا يؤثر من حيث وجوده إلا بشركة من إمكان الوجود فلا
موجد على الحقيقة إلا بوجود واجب بذاته من كل وجه لا يشوبه إمكان ولا عدم
من وجه والوسايط إن أثبتت فإنها معدات لا موجدات.
فإن قيل الممكن
باعتبار ذاته إنما يوجب غيره أو يوجد باعتبار وجوده بغيره وحين لاحظنا
جانب الوجود نقطع نظرنا عن الإمكان والعدم فإن الإمكان قد زال بثبوت
الوجود وحصل الوجوب بدل الإمكان فلا التفات إلى الإمكان أصلاً فلم يؤثر
بشركة الإمكان والجواب قلنا إذا كان الوجود من حيث هو وجود مؤثراً من غير
ملاحظة إلى وجه الإمكان والجواز فليؤثر وجود كل موجود حتى لا يكون العقل
بالإيجاب أولى من النفس أو الجسم وحتى يكون الجسم مؤثراً في الجسم باعتبار
صورته لا من حيث مادته فإن الوجود من حيث هو وجود لا يختلف وإنما الاختلاف
في كل موجود إنما يرجع إلى الفواصل.
فإن قيل العقل الأول إنما يوجب
شيئاً آخر بسبب اعتبارات في ذاته فهو من حيث وجوده بواجب الوجود يوجب
عقلاً أو نفساً ومن حيث انه ممكن بذاته يوجب جسماً هو صورة ومادة وقولكم
أن جهة الإمكان غير ملتفت إليها أصلاً باطل فإن جهة الوجوب يناسب وجود
العقل والنفس وجهة الإمكان يناسب وجود المادة والصورة وإنما حملنا على
إثبات هذا الإيجاب لأن الواحد لا يجوز أن يصدر عنه إلا واحد فإنه لو صدر
عنه اثنان لكان عن جهتين ولو ثبت أن له جهتين لتكثرت ذاته وقد دل البرهان
على أن واجب الوجود لن يتكثر.
والجواب قلنا ولو كان العقل إنما أوجب
عقلاً أو نفساً باعتبار انه واجب بغيره لا وجب الجسم جسماً أو نفساً
باعتبار انه واجب بغيره فإن قضية الوجوب بالغير لا تختلف إلا أن يكون
أحدهما بغير واسطة والثاني واسطة وإلا فمن حيث أن الجسم ذو مادة لا يمتنع
عليه الإيجاد من حيث انه واجب بغيره وكما أن العقل من حيث انه ذو إمكان في
ذاته لم يمتنع عليه الإيجاب والإيجاد من حيث انه واجب بغيره فقولوا أن
الجسم يجوز أن يوجد جسماً أو قوة في جسم يجوز أن توجب جسماً أو صورة
الجسمية يجوز أن توجب جسماً وهذا مستحيل بالاتفاق.
نعم نقول هاهنا
مقتضيات أربعة عقل ونفس وفلك ومادة وهي جواهر مختلفة متمايزة بالحقايق
تستدعي مقتضيات أربعة مختلفة بالحقائق أيضاً فعليكم أن تثبتوا في المعلول
الأول هذه الحقائق بحيث يناسب كل واحد واحد وإلا فيلزم أن يصدر عن شيء
واحد أشياء وذلك محال عندكم وعليكم أيضاً أن تثبتوا أن تلك الاعتبارات
المقتضية لا ترجع إلى إضافات وسلوب فإن كثرة الإضافات والسلوب وإن لم توجب
كثرة في الذات إلا أنها لا توجب أشياء فإن ذات واجب الوجود واحدة من كل
وجه إلا أنها لا تتكثر بالإضافات والسلوب والصفات الإضافية والسلبية لا
توجب أشياء متعددة إذ لو أوجبت لأضيف إلى واجب الوجود جميع الموجودات
إضافة واحدة من غير وسائط وذلك محال عندكم فهم بين أمرين متناقضين أن
أثبتوا في المعلول الأول صفات إيجابية مختلفة الحقائق فقد ناقضوا مذهبهم
حيث قالوا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وإن قالوا هذه الصفات التي ثبتت
إضافية أو سلبية لزمهم أن يثبتوا مقتضيات متعددة لواجب الوجود وذلك أيضاً
يناقض مذهبهم.
وهذا إلزام إفهام لا محيص عنه ثم نفصل القول بعد الإجمال
فنقول إذا كان المقتضى مفصلاً معلوماً مختلف الأنواع يجب أن يكون المقتضى
مفصلاً معلوماً مختلف الحقائق وما أثبتم إلا أمرين أحدهما كونه واجباً
بغيره والثاني كونه جايزاً بذاته وكونه واجباً بغيره أوجب عقلاً أو نفساً
وكونه ممكناً بذاته أوجب صورة ومادة فقد أثبتم صدور موجودين جوهرين قائمين
بذاتيهما من وجه واحد وذلك أيضاً يناقض مذهبهم.
وأراد من تكيس منهم أن
يعتذر عن هذين الإلزامين فقال إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كما ذكرنا
إلا أن العقل الأول إنما يكثر باعتبارات ذاته لا بما استفاد من غيره لأن
الإمكان له من ذاته لا من غيره والوجود له من غيره لا من ذاته فلم يستفد
الكثرة من واجب الوجود لعمري لما حصل العقل حصلت له اعتبارات أربعة أحدها
كونه واجباً بغيره والثاني كونه عقلاً والثالث كونه واحداً في ذاته
والرابع كونه ممكناً في ذاته فأوجب من حيث هو عقل عقلاً ومن حيث هو موجود
بواجب الوجود نفساً ومن حيث هو واحد صورة ومن حيث هو مكن مادة وهذه
الاعتبارات لما كانت مختلفة الحقائق أوجبت جواهر مختلفة الأنواع.
انظروا
بعين الاعتبار إلى هذا الاعتذار هل هو إلا تحكم محض لم يقم عليه دليل عقلي
ولا شاهد حسي بل هو أقل رتبة من طرد الفقها أرادوا بناء أشرف الموجودات
كمالاً على اعتبارات كلها ترجع إلى عبارات فنطالبهم أولاً بصحة هذه
المناسبات ولا يجدون إلى إثباتها سبيلاً.
ثم نقول كونه واجب الوجود
بغيره أمر إضافي لا محالة لأن كون واجب الوجود مبدأ وعلة أو موجباً
ومبدعاً أمر إضافي لا تتكثر به الذات فإذا كان الإيجاب إضافةً فيكون بين
الموجب والموجَب إضافة لا محالة والأمر الإضافي قد يتكثر ويتعدد ولا تتكثر
به الذات فلو صلح أن يكون موجباً في العقل الأول العقل الآخر لصح مثله في
واجب الوجود بذاته فهلا كثرت الإضافات في حق واجب الوجود حتى تتحقق له
نسبة إيجاب إلى موجب فتتكثر النسب الإضافية ولا تتكثر بها الذات وهذا كما
يقدرونه في العقل الفعال الذي هو واهب الصور على العالم الجسماني فإنه ما
من صورة تحدث في العالم إلا وهي من فيضه وسنخه ثم تختلف الصور باختلاف
الأنواع والأصناف إلى ما لا يتناهى ولا تختلف الصفات في الفايض بل هو على
نعت واحد والصور تختلف وتتكثر بحسب القوابل والحوامل ولو اختلفت النسب
فإنما هي إضافات لا صفات حقيقية كذلك يجب أن يقال في واجب الوجود بذاته
أنه ينسب إليه الكل نسبة واحدة من حيث وجودها الممكن ثم الاختلاف يحصل في
القوابل أو تكون الإضافات والسلوب كثيرة وتتعدد الموجبات بحسب تلك ولا
يوجب ذلك كثرة في الذات كما قالوا في المعلول الأول.
ونقول كون
العقل الأول عقلاً أمر سلبي عندكم لأن معنى كونه عقلاً أنه مجرد عن المادة
والتجريد عن المادة سلب المادة ونفيها والنفي كيف يناسب وجود جوهر عقلي هو
عقل كيف والسلوب كثيرة فهلا أوجب بكل سلب جوهراً عقلياً فإنه كما يسلب عنه
المادة يسلب عنه الصورة أعني الصورة الجسمية ويسلب عنه الكيفية والكمية
والوضع والحيز والمكان والزمان ولم يجب أن يقال يلزم عنه بكل سلب جوهر
عقلي ومثل هذه السلوب تتحقق في حق واجب الوجود أيضاً ولا يوجب كل سلب
جوهراً عقلياً وإن سلم ذلك حصل غرضنا من إضافة الكل إليه.
ثم نقول لم
صار كونه واجب الوجود بغيره أولى بإيجاب نفس من كونه مجرداً عن المادة ولو
عكس الأمر فجعل ما ذكرتموه بالغير موجباً للعقل وما ذكرتموه من التجرد عن
المادة موجباً للنفس أي محال كان يلزم منه وأي خلل كان يحصل وهل هذا إلا
تحكم بارد بني على تقليد أو تقليد استند إلى تحكم.
ونقول عددتم
اعتبارات أربعة وقضيتم بوحدة العقل في ذاته وقلتم أن الوحدة توجب نفساً أو
جسماً فبينوا ما هو المستفاد من الباري تعالى وما هو له من ذاته فإن الذي
له من ذاته ليس إلا إمكان الوجود بقيت اعتبارات ثلاثة وإن كانت مستفادة من
الأول استدعت ثلاث مقتضيات وواجب الوجود واحد من كل وجه وإن كانت له لذاته
أي من لوازم ذاته فقد بطل قولكم إن الذي له من ذاته هو الإمكان فقط ثم
الإمكان لا يناسب إلا المادة لأن طبيعة المادة طبيعة عدمية لها استعداد
قبول الصور والإمكان طبيعة عدمية أيضاً لها استعداد قبول الوجود بقيت
الصورة لا موجب لها.
ومما يقضى منه العجب أن الجسم الذي هو مركب من
جوهرين مختلفين مادة وصورة لا يجوز أن يوجب جسماً مثله وشيء ما له وجود
بغيره وإمكان بذاته يوجب جواهر عقلية حقيقية مختلفة بالنوع لا يجوز أن
تشترك في مادة مع أن الإمكان ليس يتحقق له وجود إلا في الذهن والمادة
يتحقق لها وجود في الخارج فعرف بهذه الاعتراضات أن الواسطة التي أوجبوا
وجودها حتى توجب الموجودات لا يحتاج إليها.
ثم نقول من أين أثبتم أربع
اعتبارات في الصادر الأول حتى صدرت عنه أربعة جواهر فما قولكم في الصادر
الثاني والثالث أفيصدر عن كل واحد على مثال ما صدر من الأول أو يتغير
الترتيب فإن كان على مثال الأول فيجب أن يصدر عن كل واحد من الأربعة أربعة
جواهر فيتضاعف الأعداد أربعة في أربعة وذلك على خلاف الوجود أو يصدر عن
العقل الثاني أربعة أخرى فما الموجب للوقوف على تسعة من العقول أو تسع من
النفوس وتسعة من الأفلاك وأربعة من العناصر فهلا زاد إلى ما لا يتناهى أو
هلا زاد بعدد معلوم أو هلا نقص فهل الانتهاء إلى عدد معلوم ثم الوقوف عليه
إلا تحكم محض ثم ما الموجب حتى يتغير التأثير من السماوي المتركب تركيباً
لا ينحل قط المتحرك تحركاً على الاستدارة لا يسكن قط إلى العناصر
والمركبات تركيباً لا يدوم قط ولا يثبت على حال قط المتحركة تحركاً على
الاستقامة ثم الانتهاء إلى النفس الإنسانية والوقوف عليها آخراً وما
الموجب لتقدير النجوم والشمس والقمر بأقدارها المعلومة حتى صار منها ما هو
أكبر ومنها ما هو أصغر وما الموجب لتعيين القطبين بالموضع المعلوم مع أن
كل كرة واحدة وليس بعض الأجزاء بتعين القطب فيه أولى من البعض فإن كنتم
شرعتم في طلب العلة لكل شيء وادعيتم أن كمال نفس الإنسان في أن تتجلى لها
حقائق الموجودات وتصرفتم بالفكر العقلي في الهيئات وكيفية الإبداع
فأفيدونا جواب هذه الأسولة وإذ رأينا انحصاركم وتحيركم ورأينا الوجود على
خلاف الترتيب الذي وضعتم ولم تستمر قاعدتكم على ما مهدتم عرف بطلان مذهبكم
من كل وجه وعلم بالضرورة استناد الموجودات إلى صانع عالم قادر مختار ابتدع
الخلق بقدرته وإرادته ابتداعاً واخترعهم على مشيئته اختراعاً ثم سلكهم في
طرق إرادته وبعثهم على سبيل محبته لا يملكون تأخراً عما قدمهم إليه ولا
يستطيعون تقدماً إلى ما أخرهم عنه وهذا القدر يكفي في هذه المسئلة من الرد
على الفلاسفة المتفقين على رأي أرسطاطاليس وسنرد على الباقين عند تعقبنا
آراء أرباب المقالات إن شاء الله تعالى.
وأما المجوس فمذهبهم يدور
على قاعدتين أحديهما ذكر سبب امتزاج النور والظلمة والثانية ذكر سبب خلاص
النور من الظلمة والأولى هي المبدأ والثانية هي المعاد وذلك انه لما ألزم
عليهم أن النور إذا كان ضد الظلمة جوهراً وطبعاً وفعلاً وحيزاً وهما
متنافران ذاتاً وطبيعةً فكيف امتزجا وما الموجب لاجتماعهما حتى حصل
الامتزاج وحصل بحصول الامتزاج صور هذا العالم ثم هل يبقى هذا الامتزاج أبد
الدهر ويلزم عليهم كون أجزاء النور معذبةً أبد الآبدين أو تتخلص يوماً ما
فما الموجب للخلاص.
فصار مدار المسئلة معهم على تقرير هذين الركنين.
قالت طائفة منهم أن النور فكر في نفسه فكرةً ردية فحدث منها الظلام
متشبثاً ببعض أجزاء النور وهذا قول من قال بحدوث الظلام.
فيقال
لهم إذا كان النور خيراً لا شر فيه بوجه ما فما الموجب لحدوث الفكرة
الردية فإن حدثت بنفسها فهلا حدث الظلام بنفسه من غير أن ينسب إليه وإن
حدث بالنور فالنور كيف أحدث أصل الشر ومنبع الفساد فإنه إن كان كل فساد في
العالم إنما انتسب إلى الظلام والظلام انتسب إلى الفكرة كانت الفكرة مبدأ
الشر والفساد.
ومن العجب أنهم اعتذروا حتى لم ينسبوا شراً جزئياً إلى النور في الحوادث
ولزمهم أن ينسبوا كل الشر وأصل الفساد إليه.
ومن
قال بقدم الظلام فالرد عليه أن العقل يقضي ضرورةً أن شيئين متنافرين غاية
التنافر طبعاً لا يمتزجان إلا بقاسر فإنهما لو امتزجا بذاتيهما بطل
تنافرهما بذاتيهما وما هو متنافر ذاتاً لا يجوز أن يجتمع ذاتاً فالذات
الواحدة لا توجب اجتماعاً وافتراقاً وذلك يقتضي ألا يحصل وجود ما وقد حصل
فهو خلف.
ونقول أيضاً الظلام لا يخلو إما أن يكون موجوداً حقيقةً أو لم
يكن فإن كان وجوده وجوداً حقيقياً فقد ساوى النور في الوجود وبطل الامتياز
عنه من كل وجه وكذلك إن ساواه في القدم والوحدة ثم الوجود من حيث هو وجود
خير لا محالة فلم يكن الظلام شراً وإن لم يكن موجوداً حقيقةً فما ليس
بموجود حقيقة كيف يكون قديماً وكيف ينافي ضده وكيف يحصل منه امتزاج وكيف
يحصل من امتزاجه وجود العالم.
ونقول أيضاً عندكم وجود خير من شر ووجود شر من خير لا يتصور.
ومن قال بحدوث الظلام فقد لزمه حدوث شر من خير ثم حدوث العالم من الامتزاج
وذلك حدوث خير من شر.
ومن
قال بقدمه فقد لزمه حصول العالم من الامتزاج والامتزاج إن كان خيراً فهو
حصول خير من شر وإن كان شراً فهو حصول شر من خير ثم لو كان الامتزاج خيراً
أوجب أن يكون الخلاص شراً لأنه ضده ولو كان شراً فالخلاص خير وعلى أي وجه
قدر فلا بد من حصول خير من شر وحصول شر من خير.
ونقول أيضاً العقل
بالضرورة يقضي بأن امتزاج جوهرين بسيطين لا يقتضي إلا طبيعةً واحدة ونحن
نرى مختلفات في العالم اختلافاً في النوع والشخص والحقيقة والصورة على
طبائع مختلفة وأعراض متضادة وهذه المختلفات تستحيل أن تحصل من امتزاج
أمرين بسيطين فقط فإنهما لا يوجبان أموراً على خلاف ذاتيهما ولا يوجدان
أكواناً على ضد طبيعتيهما فقد بطل قولهم أن الكون والكائنات حصلت من
الامتزاج بل لا بد من إسنادهما إلى فاطر حكيم قادر عليم.
وأما الكلام على المعتزلة فنذكر أولاً طريق أهل السنة في إسناد الكائنات
إلى الله سبحانه خلقاً وإبداعاً.
ولهم
طريقان في ذلك أحدهما قولهم الأفعال المحكمة دالة على علم مخترعها إذ
الاتقان والإحكام من آثار العلم لا محالة وإذا كان الفعل صادراً من فاعل
متقن فيجب أن يكون من آثار علم ذلك الفاعل ومن المعلوم أن علم العبد لا
يتعلق قط بما يفعله من كل وجه بل لو علمه علمه من وجه دون وجه علم جملة لا
علم تفصيل فوجوه الإحكام في الفعل لم تدل على علمه وليست من آثار علمه
فيتعين أن الفاعل غيره وهو الذي أحاط به علماً من كل وجه وهذه الطريقة هي
التي اعتمد عليها الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وأوردها في كتبه
وفرضها في الغافل إذا صدر عنه فعل.
والحق أن الدليل ليس بمختص
بالغافل فإن الغافل كما لم يحط علماً بالفعل من كل وجه كذلك العالم لم يحط
به علماً من كل وجه والفاعل الخالق يجب أن يكون محيطاً بالفعل من كل وجه
إذ الأحكام إنما يثبت فيه من آثار علمه لا من آثار علم غيره ويدل على علمه
لا على علم غيره فكما يستحيل إيجاد الفعل واختراعه على جهل وغفلة بالمخلوق
المخترع من كل وجه كذلك يستحيل إيجاده على غفلة من وجه قال الله تعالى "
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير " فإن قيل هذا الدليل لا يصلح لإثبات
استحالة حدوث الفعل بالقدرة الحادثة فإن إحاطة العبد بالفعل من كل وجه غير
مستحيل وإن لم يتفق في الصورة المذكورة وقوعاً لا وجوباً فلو قدر تعلق
العلم الحادث بالفعل من كل وجه وجب أن تجوزوا حصول الفعل بالقدرة الحادثة
من كل وجه لأن الأحكام والإتقان فيه دل على علم الفاعل ومع ذلك لم يجز على
أصلكم فدل أن الاستدلال بانتفاء العلم من كل وجه باطل وأيضاً فإن القدر
الذي تعلق العلم به وجب أن يكون مخلوقاً للعبد وعندنا العلم بالفعل من كل
وجه غير شرط بل العلم بأصل وجوده شرط كونه فاعلاً وهو لم يعدم ذلك.
والجواب
أنا ما أنشانا هذا الدليل لبيان استحالة حدوث الفعل بالقدرة الحادثة بل
لنفي كون العبد خالقاً لأفعاله التي يثاب ويعاقب عليها إذ لو كان خالقاً
لدل الأحكام في فعله على علمه لكن لم يدل فلم يكن خالقاً لأنه لو كان
خالقاً لكان عالماً بخلقه من كل وجه لكنه ليس بعالم به من كل وجه فليس
بخالق.
هذا وجه دلالة هذا النظر فلا يلزمنا تقدير الإحاطة به من كل وجه
فإن انتفاء العلم إذا دل على انتفاء الخالقية لم يلزم أن يدل وجود العلم
على ثبوت الخالقية بل هو عكس الأدلة والدليل لا ينعكس .
ولو تصدينا
لبيان الاستحالة صغنا الدليل صياغةً أخرى فقلنا لو كان الفعل منتسباً إلى
العبد إبداعاً لوجب أن يكون في حال إبداعه عالماً بجميع أحواله ويستحيل من
العبد الإحاطة بجميع وجوه الفعل في حالة واحدة لأمرين أحدهما أن العلم
الحادث لا يتعلق بمعلومين في حالة واحدة وذلك لجواز طريان الجهل على
العالم بأحد الوجهين فيؤدي إلى أن يكون عالماً جاهلاً بمعلوم واحد في حالة
واحدة ويكون علمه علماً من وجه وجهلاً من وجه.
الثاني أن وجوه
المعلومات في الفعل تنقسم إلى ما يعلم ضرورة وإلى ما يعلم نظراً فيحتاج
حالة الإيجاد في تحصيل ذلك العلم إلى نظر وهو اكتساب ثان وربما يحتاج إلى
معرفة الضروري والنظري من وجوه الاكتساب فيؤدي إلى التسلسل حتى لا يصل إلى
إيجاد الفعل المطلوب وعن هذا المعنى صار كثير من عقلاء الفلاسفة إلى أن
الإيجاد لن يحصل إلا بالعلم حتى لو تصور من الإنسان العلم بوجوه الفعل
كلياً وجزياً ومحلاً ومكاناً وزماناً وعدداً وشكلاً وعرضاً وكمالاً لتصور
منه الإيجاد والإبداع وعن هذا صاروا إلى أن علم الباري سبحانه بذاته هو
المبدئ لوجود الفعل الأول وفرقوا بين العلم الفعلي والعلم الانفعالي وإنما
يحتاج الإنسان إلى القدرة والإرادة والدواعي والآلات والأدوات لأن علمه لن
يتصور أن يكون علماً فعلياً بل علومه كلها انفعالية ولذلك اتفق المتكلمون
بأسرهم على أن العلم يتبع المعلوم فيتعلق به على ما هو به ولا يكسبه صفةً
ولا يكتسب عنه صفةً وهذا هو سر هذه الطريقة ونهايتها.
أما الطريق الثاني في بيان استحالة كون القدرة الحادثة صالحة للإيجاد.
فنقول
لو صلحت للإيجاد لصلحت لإيجاد كل موجود من الجواهر والأعراض وذلك لأن
الوجود قضية واحدة تشمل الموجودات وهو من حيث أنه وجود لا يختلف فليس يفضل
الجوهر العرض في الوجود من حيث أنه وجود بل من وجه آخر وهو القيام بالنفس
والحجمية والتحيز والاستغناء عن المحل وعند الخصم هذه كلها صفات تابعة
للحدوث وليست من آثار القدرة وأما الشيئية والعينية والجوهرية والعرضية
فهي أسماء أجناس عنده ثابتة في العدم ليست أيضاً من آثار القدرة فلم يبق
من الصفات وجه لتعلق القدرة إلا الوجود وهو لا يختلف في الموجودات وجهة
الصلاحية أيضاً وفي القدرة جهة واحدة فلو صلحت لإيجاد موجود ما صلحت
لإيجاد كل موجود لكنها لا تصلح لإيجاد بعض الموجودات من الجواهر وأكثر
الإعراض فلم تصلح لإيجاد موجود ما.
ومما يوضحه أن الصلاحية لو
اختلفت بالنسبة إلى موجود وموجود لاختلفت بالنسبة إلى قدرة وقدرة حتى يقال
تصلح قدرة زيد لحركة ولا تصلح قدرة عمرو لمثل تلك الحركة بل عند الخصم لما
شملت الحقيقة جميع قدر البشر استوت كلها في الصلاحية كذلك شملت حقيقة
الوجود جميع الموجودات فيجب أن تستوي في قبول أثر الصلاحية بل يمكن أن
يقال أن الصلاحية ليست تابعةً لحقيقة القدرة بل هي مختلفة بالنسب وعن هذا
صلحت للإيجاد عندهم ولم تصلح للإعادة والإعادة إيجاد ثان وصلحت لتحصيل
العلم ولم تصلح للغفلة عن ذلك العلم.
ومما يوضحه أن صلاحية القدرة لم
تخل من أحد الأمرين إما أن تثبت عموماً فيجب أن لا يختلف بالنسبة إلى
موجود دون موجود كما بينا وإما أن تثبت خصوصاً ولا دليل على التخصيص لبعض
الموجودات دون البعض سرى جريان العادة بما ألفناه من الأفعال المنسوبة إلى
العباد وسنبين أن ذلك على أي وجه يثبت وبالجملة فليس يصلح ذلك دليلاً على
حصر صلاحية القدرة فيها دون سائر الموجودات تجويزاً وإمكاناً.
فإن قيل
ألستم أوجبتم تعلق القدرة الحادثة ببعض الموجودات دون البعض وسميتم نفس
التعلق كسباً فما ذكرتموه في التعلق والكسب من التخصيص فهو جوابنا في
الإيجاد من التخصيص.
ومن العجب أنكم تنكرون تأثير القدرة الحادثة
وتثبتون التعلق فهلا جوزتم عموم التعلق حتى يتعلق بكل موجود قديم أو حادث
جوهر أو عرض فإن خصصتم التعلق مع نفي التأثير فلا تستبعدوا منا تخصيص
التعلق مع إثبات التأثير.
والجواب قلنا نحن بينا القدرة الحادثة
وتعلقها بالمقدور ولم نثبت عموم التعلق ولا لزمنا ذلك إذ لم نعين جهة
التأثير بالوجود والحدوث وأنتم عينتم جهة التأثير بالوجود من حيث هو وجود
قضية عامة فلزمكم عموم التعلق والتأثير في كل موجود واستحال على أصلكم حصر
صلاحية القدرة في بعض الموجودات دون البعض.
ولم يثبت شيخنا أبو الحسن
رحمه الله للقدرة الحادثة صلاحية أصلاً لا لجهة الوجود ولا لصفة من صفات
الوجود فلم يلزمه التعميم والتخصيص وأما القاضي أبو بكر فقد أثبت لها
أثراً كما سنذكره ولكنه يبرئ جهة الوجود عن التأثير فيه فلم يلزمه التعميم.
قال
القاضي الإنسان يحس من نفسه تفرقةً ضرورية بين حركتي الضرورية والاختيارية
كحركة المرتعش وحركة المختار والتفرقة لم ترجع إلى نفس الحركتين من حيث
الحركة لأنهما حركتان متماثلتان بل إلى زايد على كونهما حركة وهو كون
أحدهما مقدورة مرادة وكون الثانية غير مقدورة ولا مرادة ثم لم يخل الأمر
من أحد حالين إما أن يقال تعلقت القدرة بأحديهما تعلق العلم من غير تأثير
أصلاً فيؤدي ذلك إلى نفي التفرقة فإن نفي التأثير كنفي التعلق فيما يرجع
إلى ذاتي الحركتين والإنسان لا يجد التفرقة فيهما وبينهما إلا في أمر زايد
على وجودهما وأحوال وجودهما وإما أن يقال تعلقت القدرة بأحديهما تعلق
تأثير لم يخل الحال من أحد أمرين إما أن يرجع التأثير إلى الوجود والحدوث
وإما أن يرجع إلى صفة من صفات الوجود والأول باطل بما ذكرناه أنه لو أثر
في الوجود لأثر في كل موجود فتعين أنه يرجع التأثير إلى صفة أخرى وهي حال
زائدة على الوجود قال وعند الخصم قادرية الباري سبحانه لم تؤثر إلا في حال
هو الوجود لأنه أثبت في العدم سائر صفات الأجناس من الشيئية والجوهرية
والعرضية والكونية واللونية إلى أخص الصفات من الحركات والسكون والسوادية
والبياضية فلم يبق سوى حالة واحدة هي الحدوث فليأخذ مني في قدرة العبد
مثله.
فألزمه أصحابه أنك أثبت حالاً مجهولة لا ندري ما هي إذ لا اسم لها ولا
معنى.
قال
بل هي معلومة بالدليل والتقسيم الذي أرشدنا إليه كما بينا فإن لم تتيسر لي
عبارة عنها باسم خاص لم يضر ذلك ألسنا أثبتنا وجوهاً واعتبارات عقلية
للفعل الواحد وأضفنا كل وجه إلى صفة أثرت فيه مثل الوقوع فإنه من آثار
القدرة والتخصيص ببعض الجائزات فإنه من آثار الإرادة والأحكام فإنه من
دلائل العلم وعند الخصم كون الفعل واجباً أو ندباً أو حلالاً أو حراماً أو
حسناً أو قبيحاً صفات زائدة على وجوده بعضها ذاتية للفعل وبعضها من آثار
الإرادة وكذلك الصفات التابعة للحدوث مثل كون الجوهر متحيزاً وقابلاً
للعرض فإذا جاز عنده إثبات صفات هي أحوال واعتبارات زائدة على الوجود لا
تعلق بها القادرية وهي معقولة ومفهومة فكيف يستبعد مني إثبات أثر للقدرة
الحادثة معقولاً ومفهوماً ومن أراد تعيين ذلك الوجه الذي سماه حالاً
فطريقه أن يجعل حركة مثلاً اسم جنس يشمل أنواعاً وأصنافاً أو اسم نوع
يتمايز بالعوارض واللوازم فإن الحركات تنقسم إلى أقسام فمنها ما هو كتابة
ومنها ما هو قول ومنها ما هو صناعة باليد وينقسم كل قسم إلى أصناف فكون
حركة اليد كتابة وكونها صناعة متمايزان وهذا التمايز راجع إلى حال في إحدى
الحركتين تتميز بها عن الثانية مع اشتراكهما في كونهما حركة وكذلك الحركة
الضرورية والحركة الاختيارية فتضاف تلك الحالة إلى العبد كسباً وفعلاً
ويشتق له منها اسم خاص مثل قام وقعد وقائم وقاعد وكتب وقال وكاتب وقائل ثم
إذا اتصل به أمر ووقع على وفاق الأمر سمي عبادة وطاعة فإذا اتصل به نهي
ووقع على خلاف الأمر سمي جريمة ومعصية ويكون ذلك الوجه هو المكلف به وهو
المقابل بالثواب أو العقاب كما قال الخصم إن الفعل يقابل بالثواب أو
العقاب لا من حيث أنه موجود بل من حيث أنه حسن أو قبيح والقبح والحسن
حالتان زائدتان على كونه فعلاً وكونه موجوداً وهو أبعد من العدل والقاضي
أقرب إلى العدل فإنه أضاف إلى العبد ما لم يقابل بثواب أو عقاب وقابل
بالثواب والعقاب ما لم يكن من آثار قدرته والقاضي عين الجهة التي هي عنده
لم تقابل بالجزاء فأثبتها فعلاً للرب وعين الجهة التي هي فعل العبد وكسبه
فقابلها بالجزاء وذلك هو العدل.
ومما يوضح طريقة القاضي ويبين أنه ما
خالف الأصحاب تلك المخالفة البعيدة أن الفعل ذو جهات عقلية واعتبارات
ذهنبة عامة وخاصة كالوجود والحدوث والعرضية واللونية وكونه حركة أو سكوناً
وكون الحركة كتابة أو قولاً وليس الفعل بذاته شيئاً من هذه الوجوه بل هي
كلها مستفادة له من الفاعل والذي له بذاته هو الإمكان فقط وأما وجوده
فمستفاد من موجده على الوجه الذي هو به وهو أعم الوجوه وأما كونه كتابةً
أو قولاً فمستفاد من كاتبه أو قائله وهو أخص الوجوه فيتميز الوجهان تميزاً
عقلياً لا حسياً وتغاير المتعلقان تغايراً سمي أحدهما إيجاداً وإبداعاً
وهو نسبة أعم الوجوه إلى صفة لها عموم التعلق وسمي الثاني كسباً وفعلاً
وهو نسبة أخص الوجوه إلى صفة لها خصوص التعلق فهو من حيث وجوده يحتاج إلى
موجد ومن حيث الكتابة والقول يحتاج إلى كاتب وقائل والموجد لا تتغير ذاته
أو صفته لوجود الموجد ويشترط كونه عالماً بجميع جهات الفعل والمكتسب تتغير
ذاته وصفته لحصول الكسب ولا يشترط كونه عالماً بجميع جهات الفعل.
وبيان
آخر نقول جلت القدرة الأزلية عن أن يكون لها صلاحية مخصوصة مقصورة على
وجوه من الفعل مخصوصة وقصرت القدرة الحادثة عن أن يكون لها صلاحية عامة
شاملة لجميع وجوه الفعل وذلك أن صلاحية القدرة الحادثة لم تشمل جميع
الموجودات بالاتفاق فلا تصلح لإيجاد الجوهر وكل عرض بل هي مقصورة على
حركات مخصوصة والقدرة الحادثة فيها مختلفة الصلاحية حتى يمكن أن يقدر
نوعية مخصوصة في القدرة الحادثة لتنوع الصلاحية فلذلك اقتصرت على بعض
الموجودات دون البعض بخلاف قدرة الباري سبحانه فإن صلاحيتها واحدة لا
تختلف فيجب أن يكون متعلقها واحداً لا يختلف وذلك هو الوجود فإذا لم يجز
أن يضاف أخص الأوصاف إلى الباري سبحانه لأنه يؤدي إلى قصوره في الصلاحية
كذلك لا يجوز أن يضاف أعم الأوصاف إلى القدرة الحادثة لأنه يؤدي إلى كمال
في الصلاحية فلا ذاك الكمال مسلوب عن القدرة الإلهية ولا هذا الكمال ثابت
للقدرة الحادثة فينعم النظر فيه لأن فيه خلاص فلا يجوز أن يضاف إلى الموجد
ما يضاف إلى المكتسب حتى يقال هو الكاتب القائل القاعد القائم ولا يجوز أن
يضاف إلى المكتسب ما يضاف إلى الموجد حتى يقال هو الموجِد المبدع الخالق
الرازق.
وعن هذا كان الجواب المرتضى عند التمييز بين الخلق والكسب أن الخلق هو
الموجود بإيجاد الموجد ويلزمه حكم وشرط.
أما الحكم فإن لا يتغير الموجد بالإيجاد فيكسبه صفة ولا يكتسب عنه صفة.
وأما الشرط أن يكون عالماً به من كل وجه والكسب هو المقدور بالقدرة
الحادثة ويلزمه حكم وشرط.
أما الحكم فأن يتغير المكتسب بالكسب فيكسبه صفة ويكتسب عنه صفةً .
وأما الشرط فأن يكون عالماً ببعض وجوه الفعل أو نقول يلزمه التغيير ولا
يشترط العلم به من كل وجه.
وهذا
تحقيق ما قاله الأستاذ أن كل فعل وقع على التعاون كان كسباً للمستعين
وحقيقة الكسب من المكتسب هو وقوع الفعل بقدرته مع تعذر انفراده به وحقيقة
الخلق هو وقوع الفعل بقدرته مع صحة انفراده به وهذا أيضاً شرح لما قاله
الأستاذ أبو بكر أن الكسب هو أن تتعلق القدرة به على وجه ما وإن لم تتعلق
به من جميع الوجوه والخلق هو أنشأ العين وإيجاد من العدم فلا فرق بين
قوليهما وقول القاضي إلا أن ما سمياه وجهاً واعتباراً سماه القاضي صفةً
وحالاً.
ونجا أبو الحسن رحمه الله حيث لم يثبت للقدرة الحادثة أثراً
أصلاً غير اعتقاد العبد بتيسير الفعل عند سلامة الآلات وحدوث الاستطاعة
والقدرة والكل من الله تعالى.
وغلا إمام الحرمين حيث أثبت للقدرة
الحادثة أثراً هو الوجود غير أنه لم يثبت للعبد استقلالاً بالوجود ما لم
يستند إلى سبب آخر ثم تتسلسل الأسباب في سلسلة الترقي إلى الباري سبحانه
وهو الخالق المبدع المستقل بإبداعه من غير احتياج إلى سبب وإنما سلك في
مسلك الفلاسفة حيث قالوا بتسلسل الأسباب وتأثير الوسائط الأعلى في القوابل
الأدنى وإنما حمله على تقرير ذلك الاحتراز عن ركاكة الجبر والجبر على
تسلسل الأسباب ألزم إذ كل مادة تستعد لصورة خاصة والصور كلها فائضة على
المواد من واهب الصور جبراً حتى الاختيار على المختارين جبر والقدرة على
القادرين جبر وحصول الأفعال من العباد عند النظر إلى الأسباب جبر وترتيب
الجزا على الأفعال جبر وهو كالمرض يحصل عند سوء المزاج وكالسلامة تحصل عند
اعتدال المزاج وكالعلم يحصل عند تجريد العقل عن الغفلة وكالصورة تحصل في
المرآة عند التصقيل فالوسايط معدات لا موجدات وما له طبيعة الإمكان في
ذاته استحال أن يكون موجداً على حقيقة كما بينا.
أما شبهة المعتزلة فتنحصر في مسلكين أحدهما مدارك العقل والثاني مدارك
السمع.
أما
الأول فقالوا الإنسان يحس من نفسه وقوع الفعل على حسب الدواعي والصوارف
فإذا أراد الحركة تحرك وإذا أراد السكون سكن ومن أنكر ذلك جحد الضرورة
فلولا صلاحية القدرة الحادثة لإيجاد ما أراد لما أحس من نفسه ذلك قالوا
وأنتم وافقتمونا على إحساس التفرقة بين حركة الضرورة والاختيارية ولم يخل
الحال من أحد أمرين إما أن يرجع إلى نفس الحركتين من حيث أن أحديهما واقعة
بقدرته والثانية واقعة بقدرة غيره وإما أن يرجع إلى صفة في القادر من حيث
أنه قادر على أحديهما غير قادر على الثانية فإن كان قادراً فلا بد له من
تأثير في مقدوره ويجب أن يتعين الأثر في الوجود لأن حصول الفعل بالوجود لا
بصفة أخرى تقارن الوجود وما سميتموه كسباً غير معقول فإن الكسب إما أن
يكون شيئاً موجوداً أو لم يكن شيئاً موجوداً فإن كان شيئاً موجوداً فقد
سلمتم التأثير في الوجود وإن لم يكن موجوداً فليس بشيء.
وأكدوا ما
قالوه بقولهم إثبات قدرة لا تأثير لها كنفي القدرة فإن تعلقها بالمقدور
كتعلق العلم بالمعلوم ولا يجد الإنسان تفرقة بين حركتين في أن أحديهما
معلومة والثانية مجهولة ويجد التفرقة بينهما في أن أحديهما مقدورة
والثانية غير مقدورة.
قلنا وقوع الفعل على حسب الدواعي ممنوع بل هو نفس
المتنازع فيه ودعوى الضرورة فيه غير مستقيم لمخالفتنا إياكم في ذلك
ولانتقاضه عليكم طرداً وعكساً فإن أفعال النائم والساهي والغافل لم تقع
على حسب الدواعي وهي منسوبة إلى العباد نسبة الإيجاد عندكم وكثير من
الأعراض وقع على حسب الدواعي وهي غير منسوبة إلى العباد نسبة الإيجاد
عندكم بالاتفاق كالألوان التي تحصل بالصبغ والطعوم التي تحصل بالمزج
والحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة عند تقريب الأجرام بعضها من بعض
والشبع عند الطعام والري عقيب الشرب والفهم عند الإفهام إلى غير ذلك مما
أجرى الله تعالى العادة به فلا دعوى الضرورة صحيحة ولا الدليل مطرد وأنتم
مدفوعون إلى إيراد حجة على نفس ما تنازعنا فيه وهو إثبات تأثير القدرة
الحادثة في الوجود من حيث هو وجود وما ذكرتموه من التفرقة بين الحركتين
أما الوجدان فمسلم لكن لم قلتم أن أحديهما موجودة بالقدرة الحادثة فإنا قد
بينا أنها راجعة إلى أحد أمرين إما إلى صفة في المحل وإما إلى حال في
الحركة وفصلناهما أحسن تفصيل وبالجملة الإيجاد غير محسوس ولا يدرك بإحساس
النفس ضرورة فقد وجدنا للتفرقة بين الحركتين والحالتين مرجعاً ومرداً غير
الوجود أليس من أثبت المعدوم شيئاً عندكم ما رد التفرقة إلى العرضية
واللونية والحركية في أنها بالقدرة الحادثة فإنها صفات نفسية ثابتة في
العدم ولا إلى الاحتياج إلى المحل فإنها من الصفات التابعة للحدوث فلذلك
نحن لا نردها إلى الوجود فإنها من آثار القدرة الأزلية ونردها إلى ما أنتم
تقابلونه بالثواب والعقاب حتى ينطبق التكليف على المقدور والمقدور على
الجزا والدواعي والصوارف أيضاً تتوجه إلى تلك الجهة فإن الإنسان لا يجد في
نفسه داعية الإيجاد ويجد دعاية القيام والقعود والحركة والسكون والمدح
والذم وهذه هيئات تحصل في الأفعال وراء الوجود تتميز عن الوجود بالخصوص
والعموم فإن شئت سميتها وجوهاً واعتبارات وبالجملة لا تنزل في كونها
معقولة عن درجة الاختصاص ببعض الجائزات الذي هو من أثر الإرادة والأحكام
والإتقان الذي هو من أثر العلم وكون الصيغة أمراً ونهياً ووعداً ووعيداً
بالإرادة.
والسر الذي دفعنا إلى ذلك عموم تعلق قدرة الباري سبحانه
وتعالى وقادريته واستدعاؤها أعم صفات الفعل وخصوص صلاحية القدرة الحادثة
واستدعاؤها أخص صفات الفعل فإن الفعل كان مقدوراً للباري سبحانه وتعالى
قبل تعلق القدرة الحادثة أي هي على حقيقة الإمكان صلاحية والقدرة على
حقيقة الإيجاد صلاحية ونفس تعلق القدرة الحادثة لم تخرج الصلاحيتين عن
حقيقتهما فيجب أن تبقى على ما كانت عليه من قبل ثم يضاف إلى كل واحد من
المتعلقين ما هو لائق فالوجود من حيث هو وجود إما خير محض وإما لا خير ولا
شر انتسب إلى الباري سبحانه إيجاداً وإبداعاً وخلقاً والكسب المنقسم إلى
الخير والشر انتسب إلى العبد فعلاً واكتساباً وليس ذلك مخلوقاً بين خالقين
بل مقدوراً بين قادرين من جهتين مختلفتين أو مقدورين متمايزين لا يضاف إلى
أحد القادرين ما يضاف إلى الثاني.
ثم نقول نحن نعكس عليكم الدليل
فنستدل على أن الحركات ليست مخلوقة للعباد بوقوع أكثرها على خلاف الدواعي
والقصود فإن الإنسان إذا أراد تحريك يده في جهة مخصوصة على حد مضبوط عنده
مثل تحريك إصبعه على خط مستقيم لم يتصور ذلك من غير انحراف عن الجهة
المخصوصة وكذلك لو رمى سهماً وقصد أن يمضي فأخطأ أو رمى حجراً فأصاب
موضعاً وأراد أن يصيب في الرمي ثانياً لم يتأت له ذلك ويستمر ذلك في جميع
الصناعات المبنية على الأسباب فإن الاستداد والانحراف فيها مرتب على حركات
اليد والإنسان قاصر القدرة على تسديدها على حسب الداعية فإذا وجدنا
الدواعي ولم نجد التأتي ووجد التأتي ولم توجد الدواعي علمنا أن اختلاف
الأحوال والحركات دالة على مصدر آخر سوا دواعي الإنسان وصوارفه.
ومما
يوضحه أن القدرة على الشيء قدرة على مثله وعلى ضده عند الخصم فلو كانت
الحركة الأولى تحدث بإحداثه لكان قادراً على مثلها أو على ضدها مثل ما قدر
على الأولى ولكانت الحركات لا تختلف أصلاً عند اجتماع الدواعي.
المسلك
الثاني لهم في إثبات الفعل للعبد إيجاداً قولهم التكليف متوجه على العبد
بإفعل ولا تفعل فلم تخل الحال من أحد أمرين إما أن لا يتحقق من العبد فعل
أصلاً فيكون التكليف سفهاً من المكلف ومع كونه سفهاً يكون متناقضاً فإن
تقديره افعل يا من لا يفعل وأيضاً فإن التكليف طلب والطلب يستدعي مطلوباً
ممكناً من المطلوب منه وإذا لم يتصور منه فعل بطل الطلب وأيضاً فإن الوعد
والوعيد مقرون بالتكليف والجزا مقدر على الفعل والترك فلو لم يحصل من
العبد فعل ولم يتصور ذلك بطل الوعد والوعيد وبطل الثواب والعقاب فيكون
التقدير افعل وأنت لا تفعل ثم إن فعلت ولن تفعل فيكون الثواب والعقاب على
ما لم يفعل وهذا خروج عن قضايا الحس فضلاً عن قضايا المعقول حتى لا يبقى
فرق بين خطاب الإنسان العاقل وبين الجماد ولا فصل بين أمر التسخير
والتعجيز وبين أمر التكليف والطلب.
قالوا ودع التكليف الشرعي أليس
المتعارف منا والمعهود بيننا مخاطبة بعضنا بعضاً بالأمر والنهي وإحالة
الخير والشر على المختار وطلب الفعل الحسن والتحذير عن الفعل القبيح ثم
ترتيب المجازات على ذلك ومن أنكر ذلك فقد خرج عن حد العقل خروج عناد فلا
يناظر إلا بالفعل مناظرة السفسطايية فيشتم ويلطم فإن غضب بالشتم وتألم
باللطم وتحرك للدفع والمقابلة فقد اعترف بأنه رأى من المعامل شيئاً ما
وإلا فما باله غضب وتألم منه وأحال الفعل عليه وإن تصدى للمقابلة فقد
اعترف بأنه رأى من المعامل فعلاً يوجب الجزا والمكافأة.
والجواب عن ذلك من وجهين أحدهما الالزامات على مذهبهم والثاني التحقيق على
موجب مذهبنا.
الأول
أن تقول عينوا لنا ما المكلف به وما المطلوب بالتكليف فإن إجمال القول بأن
التكليف متوجه على العبد ليس يغني في تقدير أثر القدرة الحادثة وتعيينه.
فإن
قلتم المطلوب والمكلف به هو الوجود من حيث هو وجود فذلك محل التنازع وكيف
يكون الوجود هو المطلوب والوجود من حيث هو وجود لا يختلف في كونه قبيحاً
وحسناً ومنهياً عنه ومأموراً به ومن المعلوم أن المطلوب بالتكليف مختلف
الجهة فمنه ما هو واجب فعله ويثاب عليه ويمدح به ومنه ما هو واجب تركه
ويعاقب على فعله ويذم عليه.
وإن قلتم المكلف به هو جهة يستحق المدح
والذم عليه فهو مسلم وذلك الوجه ليس يندرج تحت القدرة وما اندرج لم يكن
مكلفاً به فسقط الاحتجاج بالتكليف.
فإن قيل المقدور هو وجود الفعل إلا أنه يلزمه ذلك الوجه المكلف به لا
مقصوداً بالخطاب.
قيل
لا يغنيكم هذا الجواب فإن التكليف لو كان مشعراً بتأثير القدرة في الوجود
كان المكلف به هو الوجود من حيث هو وجود لا غير ولكن تقدير الخطاب أوجد
الحركة التي إذا وجدت يتبعها كونها حسنةً وعبادة وصلاة وقربة فما هو مقصود
بالخطاب غير موجود بإيجاده فيعود الإلزام عكساً عليكم افعل يا من لا يفعل
فليت شعري أي فرق بين مكلف به لا يندرج تحت قدرة المكلف ولا يندرج تحت
قدرة غيره وبين مكلف به اندرج تحت قدرة المكلف من جهة ما كلف به واندرج
تحت قدرة غيره من جهة ما لم يكلف به أليس القضيتان لو عرضتا على محك العقل
كانت الأولى أشبه بالجبر فهم قدرية من حيث أضافوا الحدوث والوجود إلى قدرة
العبد إحداثاً وإيجاداً وخلقاً وهم جبرية من حيث لم يضيفوا الجهة التي كلف
بها العبد إلى قدرته كسباً وفعلاً كما قيل أعور بأي عينيه شاء ثم يلزمهم
الأعراض التي اتفقوا على أنها حاصلة بإيجاد الباري سبحانه وقد ورد الخطاب
بتحصيلها أو بتركها وتوجه الثواب والعقاب عليها وهي أيضاً مما يتعارفه
الناس ويتداولونه مثل الألوان والطعوم واستعمال الأدوية والسموم والجراحات
المزهقة للروح والفهم عقيب الإفهام والشبع عقيب الطعام إلى غير ذلك فإن
هذه كلها حاصلة بإيجاد الباري سبحانه وقد يرد الخطاب بتحصيلها عقيب أسباب
يباشرها العبد.
ووجه الإلزام أن الخطاب يتوجه بتحصيل أعيانها مقصوداً
ولذلك يعاقب على قدر ويمدح على قدر ومن المعلوم أن من استأجر صباغاً ليبيض
ثوبه فسوده غرم ومن قتل إنساناً بسم استوجب القود ومن أحرق ثوب إنسان أو
أغرق سفينة أو فتح بثقاً حتى هلك زرع أو هد به دار عوتب على ذلك وضمن وغرم
فمورد التكليف ما اندرج تحت القدرة وما اندرج تحت القدرة غير مورد التكليف.
والجواب
عن السؤال من حيث التحقيق إنا قد بينا وجه الأثر الحاصل بالقدرة الحادثة
وهو وجه أو حال للفعل مثل ما أثبتموه للقادرية الأزلية فخذوا من العبد ما
يشابه فعل الخالق عندكم فلينظر إلى الخطاب بافعل لا تفعل أخوطب أوجد أو لا
توجد أو خوطب أعبد الله ولا تشرك به شيئاً فجهة العبادة التي هي أخص وصف
للفعل صار عبادة بالأمر وذلك حاصل بتحصيل العبد مضاف إلى قدرته فما يضركم
إضافة أخرى نعتقدها وهي مثل ما اعتقدتموه تابعاً فالوجود عندنا كالتابع أو
كالذاتي الذي كان ثابتاً في العدم والفرق بيننا أنا جعلنا الوجود متبوعاً
وأصلاً وقلنا هو عبارة عن الذات والعين وأضفناه إلى الله سبحانه وتعالى
وجميع ما يلزمه من الصفات وأضفنا إلى العبد ما لا يجوز إضافته إلى الله
تعالى حيث لا يقال أطاع الله تعالى وعصى الله تعالى وصام وصلى وباع واشترى
وقام ومشى فلا تتغير صفاته بأفعاله فلا يعزب عن علمه ذرة من خلقه بخلاف ما
يضاف إلى العبد فإنه يشتق له وصف واسم من كل فعل يباشره وتتغير ذاته
وصفاته بأفعاله ولا يحيط علماً بجميع وجوه اكتسابه وأعماله وهذا معنى ما
قاله الأستاذ أبو إسحاق أن العبد فاعل بمعين والرب فاعل بغير معين.
وأما على طريقة الشيخ أبي الحسن رحمه الله حيث لم يثبت للقدرة أثراً.
فالجواب
عن هذه الالزامات مشكل عليه غير أنه يثبت تأتياً وتمكناً يحسه الإنسان من
نفسه وذلك يرجع إلى سلامة البنية واعتقاد التيسر بحكم جريان العادة أن
العبد مهما هم بفعل وأزمع على أمر خلق الله تعالى له قدرة واستطاعة مقرونة
بذلك الفعل الذي يحدثه فيه فيتصف به العبد وبخصائصه وذلك هو مورد التكليف
وإحساسه بذلك كإحساسه بالصفات التابعة للحدوث عندكم وإن لم تكن هي أثر
القدرة الحادثة.
ومما يوضح الجواب غاية الإيضاح أن التكليف بافعل ولا
تفعل ورد بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى في نفس المكلف به كقوله تعالى: "
إهدنا الصراط المستقيم " وكقوله تعالى " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
" وسواء كانت الهداية نفسها هي المسؤولة بالدعاء أو الثبات عليها هو
المسؤول ولا شك أن العبد لو كان مستقلاً بإنشائها بقدرته مستبداً بالثبات
عليها كان مستغنياً عن هذه الاستعانة ثم الله سبحانه يمن على من يشاء من
عباده بأن هداهم للإيمان وعند الخصم هو محمول على خلق القدرة وهي صالحة
للضدين جميعاً على السواء وذلك يبطل قضية الامتنان بالهداية قال الله
سبحانه وتعالى: " بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان " .
وتحقيق
ذلك من غير جد عن الإنصاف أن العبد كما يحس من نفسه التمكن من الفعل وتيسر
التأتي يحس من نفسه الافتقار والاحتياج إلى معين في كل ما يتصرف ويجد في
استطاعته ويتكلف فقدان الاستقلال والاستبداد بالفعل في كل ما يأتي ويذر
ويقدم ويؤخر من تصرفات فكره نظراً واستدلالاً ومن حركات لسانه قيلاً
وقالاً ومن ترددات يديه يميناً وشمالاً فيحس الاقتدار على النظر ولا يحس
الاقتدار على العلم بعد حصول النظر فإنه لو أراد أن لا يحصل لا يتمكن منه
ويحس من نفسه تحريك لسانه بالحروف ولو أراد أن يبدل المخارج ويغير الأصوات
لم يتمكن من ذلك ويحس تحريك يديه وأنملته ولو أراد تحريك جزء واحد من غير
تحريك الرباطات المتصلة لم يتمكن من ذلك وعند الخصم القدرة صالحة للأضداد
والأمثال وهي متشابهة في القادرين فالعبد مستقل بالإيجاد والاختراع وليس
إلى الباري سبحانه وتعالى من هذه الأفعال إلا خلق القدرة فحسب واشتراط
البنية من أضعف ما يتصور والحق في المسئلة تسليم التمكن والتأتي
والاستطاعة على الفعل على وجه ينتسب إلى العبد وجه من الفعل يليق بصلاحية
قدرته واستطاعته وإثبات الافتقار والاحتياج ونفي الاستقلال والاستبداد
فنجد في التكليف موردي الخطاب فعلاً واستطاعةً ويضاف في الجزاء مقابلةً
وتفضلاً والله أعلم.
القاعدة الثالثة
في التوحيد
وفيها الرد على الثنوية وتستدعي هذه المسئلة سبق ذكر الوحدانية ومعنى الواحد.قال أصحابنا الواحد هو الشيء الذي لا يصح انقسامه إذ لا تقبل ذاته القسمة بوجه ولا تقبل الشركة بوجه فالباري تعالى واحد في ذاته لا قسم له وواحد في صفاته لا شبيه له واحد في أفعاله لا شريك له وقد أقمنا الدلالة على انفراده بأفعاله فلنقم الدلالة على انفراده بذاته وصفاته.
وقالت الفلاسفة واجب الوجود بذاته لا يجوز أن يكون أجزاء كمية ولا أجزاء حد قولاً ولا أجزاء ذات فعلاً ووجوداً وواجب الوجود لن يتصور إلا واحداً من كل وجه فلا يتصور ولا يتحقق موجودان كل واحد منهما واجب بذاته وعن هذا نفوا الصفات وإن أطلقوها عليه فبمعنى آخر كما سنذكره.
ووافقهم المعتزلة على ذلك غير أنهم مختلفون في التفصيل وسنفرد لإثبات الصفات مسئلة ونذكر المذهبين فيها وهذه المسئلة مقصورة على استحالة وجود الإلهين يثبت لكل واحد منهما من خصائص الإلهية ما يثبت للثاني ولست أعرف صاحب مقالة صار إلى هذا المذهب لأن الثنوية وإن صارت إلى إثبات قديمين لم تثبت لأحدهما ما ثبت للثاني من كل وجه والفلاسفة وإن قضوا بكون العقل والنفس أزليين وقضوا بكون الحركات سرمدية لم يثبتوا للمعلول خصائص العلة كيف واحدهما علة والثاني معلول والصابية وإن أثبتوا كون الروحانيين والهياكل أزلية سرمدية مدبرة لهذا العالم وسموها أرباباً وآلهة فلم يثبتوا فيها خصائص رب الأرباب ودلالة التمانع في القرآن مسرودة على من يثبت خالقاً من دون الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى: " إذاً لذهب كل إله بما خلق " وعن هذا صار أبو الحسن رحمه الله إلى أن أخص وصف الإله هو القدرة على الاختراع فلا يشاركه فيه غيره ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت إلهين.
فدليلنا على استحالة وجود إلهين أنا فرضنا الكلام في جسم وقدرنا من أحدهما إرادة تحريكه ومن الثاني إرادة تسكينه في وقت واحد لم يخل الحال من أحد ثلاثة أمور إما أن تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى اجتماع الحركة والسكون في محل واحد في حالة واحدة وذلك بين الاستحالة وإما أن لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجز وقصور في إلهية كل واحد منهما وخلو المحل عن الضدين وذلك أيضاً بين الاستحالة وإما أن تنفرد إرادة أحدهما دون الثاني فيصير الثاني مغلوباً على إرادته ممنوعاً من فعله مضطراً في إمساكه وذلك ينافي إلاهية قال الله تعالى: " ولعلا بعضهم على بعض " وكذلك لو فرضنا في توارد الإرادة والاقتدار على فعل واحد فإما أن يشتركا في نفس الإيجاد وهو قضية واحدة لا يقبل الاشتراك وإما أن ينفرد أحدهما بالإيجاد فيكون المنفرد هو الإله والثاني يكون مغلوباً مقهوراً وكذلك لو فرضنا في فعلين متباينين حتى يذهب كل إله بما خلق فيكون استغناء كل واحد منهما عن الثاني افتقاراً إليه لأن نفس الاستغناء استعلاء وفي الاستعلاء إلزام قهر وغلبة على الثاني.
ولنزد هذا بياناً وشرحاً فإن التمانع في الفعل إن أوجب استحالة
الإلهين والتمانع في الاستغناء بالذات أدل على استحالة الإلهين.
فنقول
لو قدرنا إلاهين استغنى كل واحد منهما عن صاحبه من كل وجه خرج المستغني
عنه عن كمال الاستغناء فإن المستغنى على الإطلاق من يستغنى به ولا يستغنى
عنه فيكون كل واحد منهما مستغنى عنه فيكون مفتقراً قاصراً عن درجة
الاستغناء المطلق فلن يتصور إذاً إلاهان مستغنيان على الإطلاق " والله
الغني وأنتم الفقراء " إشارة إلى هذا المعنى.
ونقول لو قدرنا إلاهين
فإما أن يكونا مختلفين في الصفات الذاتية أو متماثلين والمختلفان يستحيل
أن يكونا إلهين لأن الصفة الذاتية التي بها تقدس الإله عن غيره إذا كانا
مختلفين فيها كان الذي اتصف بها هو الإله والمخالف ليس باله وإما أن يكونا
متماثلين في الصفات الذاتية من كل وجه فالمتماثلان ليس يتميز أحدهما عن
الثاني بالحقيقة والخاصية فإن حقيقتهما واحد بل بلوازم زائدة على الحقيقة
مثل المحل والمكان والزمان وكل ذلك ينافي الإلهية أليس لما كان السوادان
متماثلين لم يتميز أحدهما بحقيقته السوادية بل باختلاف المحل أو باختلاف
الزمان وكذلك الجوهران فدل ذلك على أن التماثل في الإلهية لن يتصور بوجه "
ليس كمثله شيء: إشارة إلى هذا المعنى.
ونقول من المعلوم أن الطريق إلى
إثبات الصانع هو الدليل بالأفعال إذ الحس لا يشهد عليه والأفعال التي
شاهدناها دلت عليه من جهة جوازها وإمكانها في ذاتها والجواز قضية واحدة
تدل على الصانع من حيث أنها ترددت بين الوجود والعدم فلما ترجح جانب
الوجود اضطررنا إلى إثبات مرجح وليس في نفس الجواز وترجحه ما يدل على
مرجحين كل واحد منهما يستقل بالترجيح فإنه لو لم يستقل بالترجيح لم يكن
إلاهاً وإنما ترجح جانب الوجود لأنه أراد التخصيص بالوجود وكما أراد علم
أنه هو المرجح فلو قدرنا مرجحاً آخر وشاركه في الترجيح بطل الاستقلال ولم
يكن علمه وإرادته وقدرته أيضاً بأن يكون هو المرجح وإن لم يشاركه في
الترجيح وكان متعطلاً لم يكن علمه وإرادته وقدرته أيضاً بأن يكون هو
المرجح بل يكون علمه متعلقاً بترجيح غيره وإرادته كذلك وإذا تعلق علمه بأن
يكون غيره هو المرجح كان محالاً أن يكون هو المرجح فإن خلاف المعلوم محال
الوقوع وكذلك إرادته تكون تمنياً وتشهياً من غيره حتى تخصص لا قصداً
وترجيحاً وتخصيصاً من ذاته فقد تطرق النقص إلى كل صفة من صفاته بل كان
مفتقراً في جميع ذلك إلى غيره والفقر ينافي الإلهية وهذه الطريقة تعضد
بيان طريقة الاستغناء وهي أحسن ما ذكر في هذه المسئلة.
سؤال على دليل
التمانع في فعلين مختلفين: فإن قيل الاختلاف الذي قدرتموه في إرادة
التحريك من أحدهما وإرادة التسكين من الآخر غير متصور فإن الإرادة تتبع
العلم والعلم يتبع المعلوم فإذا كان المعلوم هو الحركة فمن ضرورته أن يكون
المراد هو الحركة وتقدير الاختلاف في العلم غير متصور فتقدير الاختلاف في
الإرادة أيضاً غير متصور وبمنى دلالة التمانع على تحقيق الاختلاف أو
تقديره وذلك غير جائز فبطل التمسك بها.
قال الأصحاب الحركة والسكون
من جملة الجائزات جبلةً إذ ليس في وجود كل واحد منهما استحالة وإذا كانت
القدرة صالحة وتقدير الاختلاف في الإرادة متصور عقلاً فنحن نجعل المقدر
كالمحقق وإن ما يلزم من التحقيق يلزم من التقدير كتقدير قيام لون أو عرض
آخر بذاته تعالى نازل منزلة التحقيق في الاستحالة والعلم ليس يخرج الجائز
عن قضية الجواز فإن خلاف المعلوم جائز الوجود جنساً وأقول إذاً علم أحدهما
تحريكه بإرادته وقدرته أفيعلم الثاني تحريكه بإرادة نفسه وقدرته أم يعلم
تحريكه بإرادة غيره وقدرته فإن علم ذلك موجوداً بإرادته وقدرته أم يعلم
تحريكه بإرادة غيره وقدرته فإن علم ذلك موجوداً بإرادته وقدرته فيكون
العلم الثاني جهلاً لا علماً وإن علمه موجوداً بإرادة غيره وقدرته فيكون
الغير إلاهاً عالماً مريداً قادراً ويكون الثاني متعطلاً ولم يوجد له إلا
علم متعلق بفعل غيره فقط وإما إرادته لفعل غيره وقدرته على فعل غيره
فتقديرهما مستحيل الوجود أو ناقص الوجود فإن أخص وصف الإرادة ما يتأتى به
التخصيص وأخص وصف القدرة ما يتأتى بها الإيجاد والإبداع وهما إذا تعلقا
بفعل الغير خرجا عن أخص حقيقتهما ففي تعطيلهما عن الفعل بعد جواز الفعل
إبطال حقيقتهما ولهذا قلنا أن معنى فاعلية الباري سبحانه وتعالى أنه لم
علم وجود شيء في وقت مخصوص أو تقدير وقت إراده على مقتضى علمه وأوجده
بقدرته على مقتضى إرادته من غير أن تتغير ذاته أو صفة من صفاته وعلمه
وإرادته وقدرته فيشبه أن يقال لزم كونه ضرورة ولكنا لا نطلق هذا اللفظ
ملاحظة منا جانب الإرادة والقدرة حتى لا يلزمنا الإيجاب بالذات وذلك ينافي
الكمال فنحن إنما عرفنا الجواز في الجائزات بقضية عقلية ضرورية وعرفنا
استناد وجود الموجودات إلى عالم قادر مريد لضرورة الاحتياج في الجائزات
فإن قدرناهما على كمال الاقتدار والاستبداد بالفعل والإبداع والتساوي في
صفات الذات وصفات الفعل حتى يكون كل واحد منهما هو الموجد بقدرته وإرادته
وعلمه وقع التمانع في الفعل وإن قدرناهما على تسليم أحدهما للثاني في جميع
ما اشتغل به كان المسلّم عبداً والمسلّم إليه إلاهاً حقاً وإن كان كل واحد
منهما مستقلاً في بعض مسلماً في بعض كان كل واحد منهما محتاجاً من وجه
وغنياً من وجه قاصراً من حيث الفعل كاملاً من حيث القوة فلا يكون إلاهين
بل محتاجين إلى كامل من كل وجه فإذاً لا يتصور في العقل تقدير موجودين على
كمال الاستقلال ولا في التجويز العقلي تقدير قادرين على التساوي في كمال
الاقتدار ولا مريدين ولا عالمين على التماثل في كمال الإرادة والعلم بل
ولا ذاتين متساويين من جميع الوجوه من غير أن يختص إحداهما عن الثانية إما
بإشارة إلى هذا أو ذلك أو محل مميز أو مكان محيز وزمان مقدم ومؤخر أو بفعل
خاص أو أثر يدل على تغاير المصدر وتباين المظهر ولهذا قلنا أن الواحد
مدلول الفعل ولو قدرنا ثانياً وثالثاً لتكافوا من حيث العدد.
ولقد
استهزأ بهذه الطريقة من لم يدرك غورها وأمكن تقريرها من وجهين: أحدهما أن
الفعل قد دل على وجود صانع للعالم مريد قادر فإن قدر ثان فلا يخلو إما أن
يكون له دليل خاص على وجوده أو يجوز عقلاً بأن يقال كما لا دليل على وجوده
ولا دليل على انتفائه فإن له دليلاً بأن يخلق عالماً آخر غير العالم
المعين فيؤدي إلى قصور في الإلهين جميعاً كما بينا وإن جوز ذلك فيجب أن
يكون عالماً بأن يخلق مريداً لأن يخلق قادراً على أن يخلق وإذا لم يخلق دل
على أنه لم يرد وإذا لم يرد علم أن لا يخلق والإله يجب علمه بأن يخلق
ويريد بأن يخلق حتى يكون مثلاً للأول فإنما ليس بمثل له ليس بإلاه.
والوجه
الثاني في تقرير التكافي أن الأمر لا يخلو إما أن يقف في عدد معلوم
فيستدعي الاقتصار على عدد محصور مقتضياً حاصراً فإن الكمية من حيث العدد
كالكمية من حيث المساحة أليس لو كان واحداً ذا حجم وعظم مشكل اقتضى مشكلاً
لذلك إذا كان ذا مقدار وعدد اقتضى مقدراً وإن لم يقف في عدد معلوم اقتضى
أعداداً غير متناهية محصورة في الوجود غير مترتبة وذلك محال وبالجملة ما
لا دليل عليه عقلاً فتجويز وجوده تقدير عقلي والمجوز عقلاً المقدر ذهناً
ليس بإلاه.
فلا تغفل عن هذه الدقيقة وافرق في المعقولات بين تقدير
المحال لفظاً أو فرضاً وبين تجويزه عقلاً أو عقداً واعلم أن التقدير
المذكور في الكتاب فرض محال لفظاً ليس بطلانه عقلاً.
سؤال على وجه
دلالة الفعل فإن قيل صادفنا في الموجودات خيراً أو شراً أو نظماً وفساداً
ووجه دلالة الخير يخالف وجه دلالة الشر بل وجود الخير يدل على مريد الخير
ووجود الشر يدل على مريد الشر ومريد الخير على الإطلاق لا يكون مريداً
للشر على الإطلاق كما أن مريد الخير في فعل مخصوص لا يكون مريد الشر في
ذلك الفعل بعينه فاختلاف وجه دلالة الفعل بالتضاد دل على اختلاف الفاعلين
بالتضاد وكما أنكم استدللتم بأنه لو كان معه إلاه لفسدت السموات والأرض
فنحن نستدل بفساد فيهما خيراً أو شراً على إلاهين اثنين.
والجواب على
قاعدة المتكلمين: قال المحققون منهم وجه دلالة الفعل على الفاعل هو الجواز
والإمكان وترجح جانب الوجود على العدم وذلك لم يختلف خيراً كان أو شراً
فالوجود من حيث هو وجود خير كله أو يقال لا خير فيه ولا شر والفعل من حيث
وجوده ينسب إلى الفاعل لا من حيث هو خير أو شر والفاعل يريد الوجود من حيث
هو وجود لا من حيث هو خير أو شر بل الخير والشر إما أمران إضافيان بأن
يكون شيء خيراً بالإضافة إلى شيء شراً بالإضافة إلى شيء وإما أمران شرعيان
فيرجع الحسن والقبح والخير والشر فيه إلى قول الشارع افعل لا تفعل وهذا هو
جوابنا عن قول المعتزلة حيث قالوا في إرادة الكائنات أنه لو كان مريداً
للشر لكان شراً فإن الشر لم ينسب إليه إلا من جهة وجوده والوجود من حيث هو
وجود لا شر فيه وهو مريد لموجود بمعنى أنه على صفة يتأتى منه التخصيص
بالوجود دون العدم وببعض الجائزات دون البعض فلم يكن مريداً للشر في
الحقيقة.
ونقول للتنويه أنا كما صادفنا في الموجودات خيراً وشراً
متمايزين فقد صادفنا في الموجودات خيراً وشراً مختلطين فإن عالم الخير
المحض هو عالم الملائكة وعالم الشر المحض هو عالم الشياطين وعالم الاختلاط
والامتزاج هو عالم البشر فهلا أثبتم ثالثاً ينسب إليه الامتزاج فإن
الممتزج من حيث هو ممتزج على طبيعة غير ما كان المنفرد عليها فهلا كانت
الطبيعة المذكورة دالة على ثالث لكن قلتم الخير والشر لم يختلفا بالامتزاج
بل دلالتهما واحد كمذلك نقول لم يختلفا في الوجود فإن دلالة الوجود واحدة.
وقد
سلك الفلاسفة الإلهيون طريقة أخرى في الوحدانية فأجابوا عن هذا السؤال على
طريقتهم: فأما طريقتهم قالوا قد شهد العقل الصريح بأن الوجود ينقسم إلى ما
يكون واجباً في ذاته وإلى ما يكون ممكناً في ذاته وكل ممكن فإنما يترجح
جانب الوجود منه على جانب العدم بمرجح فإما أن تذهب الممكنات إلى غير
نهاية أو تقف على واجب بذاته غير ممكن لكنها لو ذهبت إلى غير النهاية لما
وجدت إذ كان يتوقف وجود كل ممكن على سبق وجود مرجحه وذلك محال فلا بد أن
يقف على واجب بذاته ثم الواجب بذاته لا يجوز أن يكون لذاته مبادي يجتمع
منها واجب الوجود لا أجزاء كمية ولا كالمادة والصورة والجنس والفصل فإن
المبادي يجب أن تكون سابقة على ذات واجب الوجود ويكون واجباً بها لا بذاته
وقد فرضنا الواجب بذاته فهذا خلف ولو قدرنا اثنين واجبي الوجود اشتركا في
كون كل واحد منهما واجب الوجود فلا بد أن ينفصل أحدهما عن الثاني بفصل
يخصه فيكون وجوب الوجود مشتركاً فيه وهو ذاتي لهما فيكون جنساً وما يخص
أحدهما دون الثاني فصلاً ويكون ذاته متركباً منهما ويجب أن تكون الأجزاء
متقدمة بالذات على ذاته فهو خلف فإذا نوع واجب الوجود سواء أطلق إطلاقاً
أو خصص تخصيصاً لا يجوز أن يكون إلا واحداً فوجوده وجوبه ووجوبه حقيقته
وحقيقته وحدته ووحدته تخصصه وتعينه من غير أن يتمايز وجوب عن وجود ووجود
عن ماهية وحقيقة وعن هذا نفوا صفات الباري تعالى زائدة على الذات كما
سيأتي تفصيل ذلك في مسئلة الصفات إن شاء الله تعالى.
ثم جرحوا دلالة الخير والشر بل وقوع الشر في الوجود على مذهبهم.
بأن
قالوا الشر لا معنى له إلا عدم وجود أو عدم كمال وجود والعدم يدخل في
القضاء بالعرض لا بالذات بل القصد الأول في الإبداع ان يكون وجود ثم
القسمة العقلية أن يكون وجود هو خير محض أو يكون وجود لا يتحقق حصوله إلا
على أن يتبعه شر أما وجود الشر المحض فهو مستحيل بل الوجود الذي أكثره شر
كذلك فلا وجود وجود يتبعه شر قليل أكثر شراً من وجوده فالشر داخل في
الوجود بالقصد الثاني ولا دلالة له على مدلول إذ لا حقيقة لوجوده كما
بيناه.
وقد سلكت المعتزلة طريق التمانع في استحالة الإلهين كما سلكناه
ولم يستمر لهم ذلك حيث جوزوا اختلافاً في إرادة الباري سبحانه وإرادة
العبد واختلافاً في الفعل فلا تمانع.
وسلك الكعبي طريقاً آخر وقال لو
قدرنا قائمين بأنفسهما لا يتميز أحدهما عن الأخر بزمان أو بمكان أو حيز
ولا يكون لأحدهما حقيقة خاصية يمتاز أحدهما عن الثاني بها فهو مستحيل
عقلاً والخصم ريما يقول هذا هو نفس النزاع عبرت عنه تعبيراً وصيرته دليلاً
فإن جماعة من العقلاء صاروا إلى إثبات جواهر عقلية من عقول مجردة ونفوس
مجردة قديمات قائمات بأنفسها ويمتاز بعضها عن بعض بخواص وحقائق ولم تمنع
العقول ثبوتها ومن أراد أن يسلك هذه الطريقة فلا بد أن يزيد فيها شروطاً
حتى يتحقق الاستحالة وتتضح للعقل والله أعلم.
القاعدة الرابعة
في إبطال التشبيه
وفيها الرد على أصحاب الصور وأصحاب الجهة والكرامية في قولهم إن الرب تعالى محل للحوادث.فمذهب أهل الحق أن الله سبحانه لا يشبه شيئاً من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها بوجه من وجوه المشابهة والمماثلة " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير " فليس الباري سبحانه بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا في مكان ولا في زمان ولا قابل للأعراض ولا محل للحوادث.
وسارت الغالبة من الشيعة إلى نوعي تشبيه أحدهما تشبيه الخالق بالخلق فقالت المغيرية والبيانية والهاشمية ومن تابعهم إنه الإله ذو صورة مثل صور الإنسان ونسج على منوالهم جماعة من مشبهة الصفاتية متمسكين بقوله صلى الله عليه وسلم " خلق الله آدم على صورة الرحمن " وفي رواية على صورته والنوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق.
فقالت هؤلاء من الغالبة وجماعة أخرى أن شخصاً من الأشخاص إله أو فيه جزء من الإله والإله سبحانه وتعالى عن قولهم متشخص به نسجاً على منوال النصارى والحلولية في كل أمة ومن الكرامية من صار إلى أنه جوهر وجسم.
وأطبقوا على أنه بجهة فوق وأنه محل الحوادث قالوا إذا خلق الله سبحانه جوهراً أحدث في ذاته إرادة حدوثه وربما احترزوا عن لفظ أحدث فقالوا حدثت له إرادة حدوثه وكاف ونون وإذا كان المحدث مسموعاً حدث له تسمع وإذا كان مبصراً حدث له تبصر فتحدث له خمس من الصفات الحادثة بكل محدث أحدثه وربما احترزوا عن إطلاق لفظ الحلول والمحل وإن أطلقوا الاتصاف بالحادث وفرقوا بين المشيئة والإرادة فقالوا مشيئة قديمة وإرادة حادثة ولذلك فرقوا بين التكوين والمكون والأحداث والمحدث والخلق والمخلوق فالخلق حادث في ذاته والمخلوق مباين وكذلك التكوين عبارة عن قوله كن والقول قائم بذاته والمكون مباين وكذلك كلامه تعالى صفات تحدث له وهي عبارات منتظمة من حروف وأصوات عند بعضهم وعند بعضهم من حروف مجردة فهو حادث ليس بقديم ولا محدث وأحالوا فناء ما حدث من الصفات في ذاته ولم يطلقوا لفظ التقدم والتأخر على الحروف والكلمات واجتهد محمد بن الهيصم منهم في كل مسئلة من مسائل التشبيه حتى رد الخلاف فيها إلى ما يسوغ أن يذكر ولا يسفه غير مسئلة الحوادث فإنه تركها على التكال الأول بعلم صاحبه أبي عبد الله الكرام.
لنا دليل شامل يعم إبطال مذاهب المشبهة جملة وعلى كل فرقة ممن عددناهم حجة خاصة ونقض على الانفراد فنبتدي بالأعم.
ونقول
التقدر بالأشكال والصور والتغير بالحوادث والغير دليل الحدوث فلو كان
الباري سبحانه متقدراً بقدر متصوراً بصورة متناهياً بحد ونهاية مختصاً
بجهة متغيراً بصفة حادثة في ذاته لكان محدثاً إذ العقل بصريحه يقضي أن
الأقدار في تجويز العقل متساوية فما من قدر وشكل يقدره العقل إلا ويجوز أن
يكون مخصوصاً بقدر آخر واختصاصه بقدر معين وتميزه بجهة ومسافة يستدعي
مخصصاً ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ذاتاً لم تكن موصوفة بصفة ثم صارت
موصوفة فقد تغيرت عما كانت عليه والتغير دليل الحدوث فإذا لم يستدل على
حدوث الكائنات إلا بالتغير الطارئ عليها وبالجملة فالتغير يستدعي مغيراً
خارجاً من ذات المغير والمقدر يستدعي مقدراً.
فإن قيل بم تنكرون على من
يقول إن القدر الذي اختص به نهاية وحد واجب له لذاته فلا يحتاج إلى مخصص
والمقادير التي هي في الخلق إنما احتاجت إلى مقدر لأنها جائزة وذلك لأن
الجواز في الجائزات إنما يعرف بتقدير القدرة فلما كانت المقادير الخلقية
مقدورة عرف جوازها واحتاج الجواز إلى مرجح فإذا لم يكن فوق الباري سبحانه
قادر يقدر عليه لم تكن إضافة الجواز وإثبات الاحتياج له ألسنا اتفقنا على
أن الصفات ثمان أفهي واجبة له على هذا العدد أم جائز أن توجد صفة أخرى.
فإن
قلتم يجب الانحصار في هذا العدد كذلك نقول الاختصاص بالحد المذكور واجب له
إذ لا فرق بين مقدار في الصفات عدداً وبين مقدار في الذات حداً.
فإن قلتم جائز أن توجد صفة أخرى فما الموجب للانحصار في هذا الحد والعدد
فيحتاج إلى مخصص حاصر.
والجواب
قلنا المقادير من حيث أنها مقادير طولاً وعرضاً وعمقاً لا تختلف شاهداً
وغائباً في تطرق الجواز العقلي إليها واستدعاء المخصص فإنا لو قدرنا مثل
ذلك المقدار بعينه في الشاهد تطرق الجواز العقلي إليه واختصاصه به دون
مقدار آخر يستدعي المخصص وتطرق الجواز إلى الجائزات لا يتوقف على تقدير
القدرة عليها بل معرفة ذلك بينة للعقل ضرورية حتى صار كثير من العقلاء إلى
أن العقل نفسه عبارة عن علوم ضرورية هي معرفة الجواز في الجائزات
والاستحالة في المستحيلات والوجوب في الواجبات وتقدير القدرة عليها إنما
يحتاج إليه في ترجيح أحد الجائزين على الثاني لا في تصور نفس الجواز.
وهذه
نكثة قد أغفلها كثير من أصحاب الكلام وأما الصفات وانحصارها في ثمان فقد
اختلف الجواب عنه بوجوه منها أنهم منعوا إطلاق لفظ العدد عليها فضلاً عن
الثمانية.
وقالوا قد دل الفعل بوقوعه على أن الفاعل قادر وباختصاصه
ببعض الجائزات على أنه مريد وبأحكامه على أنه عالم وعلم بالضرورة أن
القضايا مختلفة وورد في الشرع إطلاق العلم والقدرة والإرادة ولا مدلول سوا
ما دل الفعل عليه أو ورد في الشرع إطلاقه ولهذا اقتصرنا على ذلك فلو سئل
هل يجوز أن يكون له صفة أخرى اختلف الجواب عنه فقيل لا يتطرق الجواز إليه
فإنا لم نثبت له الصفات بطريق التجويز العقلي بل بدليل الفعل والفعل ما دل
إلا على تلك الصفات وقيل يجوز عقلاً إلا أن الشرع لم يرد به فيتوقف في ذلك
ولا يضرنا الاعتقاد إذا لم يرد به تكليف فينسب إلى المكلف تقصير ومنها
أنهم فرقوا في الشاهد بين الصفات الذاتية التي تلتئم منها حقيقة الشيء
وبين المقادير العرضية التي لا مدخل لها في تحقيق حقيقة الشيء فإن الصفات
الذاتية لا تثبت للشيء مضافة إلى الفاعل بل هي له من غير سبب والمقادير
المختلفة تثبت للشيء مضافة إلى الفاعل فإن جعلها له بسبب ومنها أنهم قالوا
لو قدرنا صفة زائدة على الصفات الثمانية لم يخل الحال فيها إما أن تكون
صفة مدح وكمال أو تكون صفة ذم ونقصان فإن كانت صفة كمال فعدمها في الحال
نقص وقد اتصف الباري سبحانه بصفات الكمال من كل وجه وإن كانت صفة نقصان
فعدمها عنه واجب وإذا بطل القسمان تعين أنه لا يجوز أن يتصف بصفة زائدة
على الصفات الذاتية ويترتب على ما ذكرناه أنه هل يجوز لباري سبحانه أخص
وصف لا ندركه وفرق بين هذا السؤال والسؤال الأول فإن السائل الأول سأل هل
يجوز أن تزيد صفة على الصفات الثمانية والسائل الثاني سأل هل له أخص وصف
به يتميز عن المخلوقات.
واختلف جواب الأصحاب عنه أيضاً فقال بعضهم
ليس له أخص وصف ولا يجوز أن يكون لأنه بذاته وصفاته يتميز عن ذوات
المخلوقات وصفاتها من حيث أن ذاته لا حد لها زماناً ومكاناً ولا يقبل
الانقسام فعلاً ووهماً بخلاف ذوات المخلوقات وصفاتها فإنهما غير متناهية
في التعلق بالمتعلقات فلو كان الغرض أن يتحقق أخص وصف يه يقع التميز فقد
وقع التميز بما ذكرنا فلا أخص سوا ما عرفنا.
وقال بعضهم له أخص وصف
الإلهية لا ندركه وذلك أن كل شيئين لهما حقيقتان معقولتان فإنهما يتمايزان
بأخص وصفيهما وجميع ما ذكرنا من أن لا حد ولا نهاية ولا انقسام للذات ولا
تناهي للصفات كل ذلك سلوب وصفات نفي وبالنفي لا يتميز الشيء عن الشيء بل
لا بد من صفة إثبات يقع بها التميز وإلا فترتفع الحقيقة رأساً.
ثم إذا
أثبت أن له أخص الوصف فهل يجوز أن ندركه؟ قال إمام الحرمين لا يجوز أن
ندركه أصلاً وقال بعضهم يجوز أن يدرك وقال ضرار بن عمرو يدرك عند الروية
بحاسة سادسة ونفس المسئلة من محارات المتكلمين وتصوير الأخص من محارات
العقول.
فإن قيل إذا قدر موجودان قائمان بأنفسهما بحيث لا يكون أحدهما
بحيث يكون الثاني كالعرض في الجوهر فمن الضرورة إما أن يكونا متجاورين
وإما أن يكونا متباينين وعلى الوجهين جميعاً يجب أن يكون كل واحد منهما
بجهة من الثاني وربما عبروا عن هذا المعنى بأن قالوا الباري سبحانه لا
يخلو إما أن يكون داخل العالم أو خارجاً عن العالم وكما أن الدخول بالذات
يقتضي مجاورة وومماسة والخروج بالذات يستدعي مباينةً وجهةً وربما شككوا
أبلغ تشكيك على سبيل الإلزام.
فقالوا اتفقنا على أن له سبحانه ذاتاً
وصفات ومن المعلوم أن الصفات لا تكون كل واحدة بحيث الثانية ولا منحازة
عنها بجهة فإن القائم بالغير لا يقبل التحيز رأساً بل هي كلها قائمة بذاته
أي بحيث ذاته فقد تحقق التميز بين الذات والصفات وذلك راجع إلى أن الذات
لها حيث حتى تكون الصفات بحيث هو والصفات لا حيث لها فلا تكون الذات بحيث
هي وما قيل التحيث بالنسبة إلى الصفات فلو قدر قائم بذات آخر فمن ضرورته
أن لا يكون بحيث هو حتى يتحقق فرق بين الصفات التي هي بحيث هو وبين ذلك
القائم بذاته الذي ليس بحيث هو فيثبت له جهة ما ينحاز بها عنه وقد ورد
السمع بأن تلك الجهة هي جهة فوق قال الله تعالى: " وهو القاهر فوق عباده "
فأثبتنا الجهة عقلاً وأثبتنا الفوقية سمعاً واستنبطنا من النص الوارد فيه
معنى وهو كون الفوق أشرف الجهات وأليق بكمال الصمدية ولهذا تعلقت القلوب
بالسماء ورفعت الأيدي ودلت عليها إشارة الخرساء وإليها كان معراج سيد
الأنبياء.
والجواب قلنا هذه الشبهات كلها نشأت من اشتراك في لفظ القائم
بالنفس فإن عندنا يطلق هذا اللفظ في حق الباري سبحانه بمعنى أنه مستغن عن
المحل والحيز جميعاً ويطلق على الجوهر بمعنى أنه مستغن عن المحل فقط
والمستغنى على الإطلاق في مقابلة المحتاج على الإطلاق والمستغنى عن المحل
والحيز في مقابلة المحتاج إلى المحل والمحتاج إلى الحيز فلننقل العبارة
إلى هذه الجهة حتى يتبين أنكم جعلتم نفس النزاع دليلاً متمسكين باشتراك في
العبارة دون المعنى ونقول قدرناه مستغنياً عن المحل والحيز ومحتاجاً إلى
الحيز فيجب أن يكونا إما متجاورين أو متباينين محال تقديره فإن التجاور
والتباين من لوازم التحيز في المتحيزات فالمستغني عن التحيز كيف يكون إما
متجاوراً وإما متبايناً هذا كمن يقول القائمان بأنفسهما إما أن يكونا
مجتمعين أو مفترقين متحركين أو ساكنين قيل الاجتماع والافتراق من لوازم
التحيز والتحدد ولا حيز له سبحانه ولا حد ولا اجتماع ولا افتراق بل إذا
فتش على المجاورة والمباينة لم يتحقق منه إلا نفس الاجتماع والافتراق وما
جاور أو باين فقد تناهى ذاتاً والمتناهي إذا اختص بمقدار استدعي مخصصاً.
وكذلك
الجواب عن الدخول والخروج فإنا نقول ليس بداخل في العالم ولا خارج لأن
الدخول والخروج من لوازم المتحيزات والمحدودات ولهذا لا يطلقان على
الأعراض وهما كالاجتماع والافتراق والحركة والسكون وسائر الأعراض التي لا
تختص بالإجرام التي لا حياة لها ولو قيل هو الله سبحانه داخل في العالم
بمعنى العلم والقدرة وخارج عن العالم بمعنى التقدس والتنزيه كان معنى
صحيحاً كما ورد في التنزيل " وهو القاهر فوق عباده " وقد ورد " وهو معكم
أينما كنتم " " ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " وقوله سبحانه " إني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعاني " الآية بل الآيات الدالة على القرب أكثر من
الآيات الدالة على بعد الفوق وكما ورد " وهو الذي في السماء إله " وورد
مقروناً به " وفي الأرض إله " وبالجملة من تصور وجوده وجوداً مكانياً طلب
له جهة ما وانحيازاً عن العالم ببينونة متناهية أو غير متناهية كما أن من
تخيل وجوده زمانياً طلب له مدة وتقدماً على العالم بأزمنة متناهية أو غير
متناهية وكلا التخييلين باطل فهو الأول والآخر إذ ليس وجوده سبحانه
زمانياً والظاهر والباطن إذ ليس وجوده مكانياً.
وأما الشك الثاني الذي
أوردوه على سبيل الإلزام وهو الاتفاق من الكرامية والصفاتية أن لله سبحانه
ذاتاً وصفات والصفات قائمة بالذات وليست كل صفة بحيث الثانية بل بحيث
الذات.
قيل من أثبت الصفات الأزلية قائمة بذات الباري تعالى ليس يعني
بالقيام ما عنيتم ولا أطلق أنها بحيث هو كما أطلقتم بل يعني بالقيام وصف
الباري سبحانه وتعالى بها والوصف من حيث هو وصف لا يقتضي أن يكون الموصوف
بحيز وجهة ثم الحكم للوصف بأنه معنى موجود أو حال فهو بمعنى آخر وإلا
فمجرد الوصف والصفة من حيث هو وصف لا يقتضي ذلك ثم إطلاق لفظ الحيث أيضاً
قد اتسع حتى يقال هذا في العرض من حيث هو موجود له حكم ومن حيث هو عرض له
حكم وليس يعني بإطلاق لفظ الحيث إلا الاعتبار العقلي والوجوه العقلية
والحاصل في هذا السؤال أن الألفاظ التي أوردوه كلها مشتركة ولفظ القائم
بالذات والقائم بالغير ولفظ الدخول والخروج ولفظ الحيث والجهة وبالجملة
فليعلم أن جهات الأجسام من أحكام النهايات في الأجسام حتى لو قدر مقدر
جسماً غير متناه بالفعل لم يكن للجهات معنى فلا يكون فوق وتحت ويمين ويسار
وقدام وخلف ولذلك تتحقق إليها الإشارة ولذواتها اختصاص وانفراد من جهة
أخرى وإذا كانت الأجسام كرية أي مدورة فيكون تجدد الجهات على سبيل المحيط
والمحاط والفوق والسفل فيها على سبيل المركز والمحيط فإن قدر العالم كري
الشكل إما تقديراً أوجد عليه حقيقةً وإما تقديراً يجوز أن يوجد عليه
تصوراً قيل إن الباري سبحانه بجهة من العالم فيكون لا محالة محيطاً بكل
العالم وإلا فيخلو عن ذاته طرف من جهات الفوق وعندهم هو فوق العالم بأسره
فهو خلف فيلزم عليه فوقاً بالنسبة إلى من هو على الأرض على موازاة القطب
الشمالي وتحت بالنسبة إلى من هو عليها على موازاة القطب الجنوبي بل يكون
بعض منه فوقاً وبعض منه تحتاً وذلك محال وإما تعلق القلوب بالسماء ورفع
الأيدي عليها والنزول إليها بل العرش قبلة الدعاء والأرض مسجد الصلاة
والكعبة وجهة الوجه وموضع السجود قبلة العين وأقرب ما يكون العبد من الرب
إذا كان في السجود واسجد واقترب.
ومما أوجب التشبيه قيام الحوادث
بذاته سبحانه وقد ذهبت الكرامية إلى جواز ذلك ومن مذهبهم إنما يحدث من
المحدثات فإنما يحدث بإحداث الباري سبحانه والأحداث عبارة عن صفات تحدث في
ذاته من إرادة لتخصيص الفعل بالوجود ومن أقوال مرتبة من حروف مثل قوله كن
وأما سائر الأقوال كالأخبار عن الأمور الماضية والآتية والكتب المنزلة على
الرسل عليهم السلام والقصص والوعد والوعيد والأحكام والأوامر والنواهي
والتسمعات للمسموعات والتبصرات للمبصرات فتحدث في ذاته بقدرته الأزلية
وليست هي من الأحداث في شيء وعلى طريقة إنما الأحداث في الخلق على مذهب
أكثرهم قول وإرادة والقول هما صورتان هما حرفان وعلى طريقة محمد بن الهيصم
الأحداث إرادة وإيثار وذلك مشروط بالقول شرعاً وجوز بعضهم تعلق أحداث واحد
بمحدثين إذا كانا من جنس واحد وأكثرهم على أن لكل محدث أحداث فيحدث في
ذاته لكل محدث خمس صفات إرادة وكاف ونون وتسمع وتبصر وقد أثبتوا مشيةً
قديمةً تتعلق بالحادث والمحدث والأحداث والخلق ثم قالوا هذه الحوادث لا
تصير صفات لله تعالى وإنما هو خالق بخالقيته لا بخلق مريد بإراديته لا
بإرادة قائل بقائليته وهي واجبة البقاء ويستحيل عدمها بعد وجودها في ذاتها.
وللمتكلمين عليه طريقان في الكلام أحدهما البرهان والثاني المناقضة في
الإلزام.
أما
البرهان فنقول لو قامت الحوادث بذات الباري سبحانه وتعالى لاتصف بها بعد
أن لم يتصف ولو اتصف لتغير والتغير دليل الحدوث إذ لا بد من مغير وتحقيق
المقدمة الأولى أن معنى قيام الأعراض بمحالها كونها أوصافاً لها كالعلم
إذا قام بجوهر وصف الجوهر بأنه عالم وكذلك سائر المعاني والأعراض فليس ذلك
كالوصف بكون الباري تعالى خالقاً صانعاً على مذهب من لم يفرق بين الخلق
والمخلوق فإن المخلوق لا يقوم بذات الخالق والخلق قائم بذاته تعالى عندكم
فيجب أن يكون وصفاً له وكذلك يقال أراد فهو مريد بإرادة وقال فهو قائل
بقول وإذا تحقق كونه وصفاً له بعد أن لم يكن موصوفاً به فقد تحقق التغير
والتغير خروج شيء إلى غير ما كان عليه ولا يشترط فيه بطلان صفة وتجدد صفة
فإنه إذا كان خالياً من صفات ثم اعتراه صفات فقد تغير عما كان عليه فليس
للخصم اعتراض على هذه الطريقة إلا منع الاتصاف أو منع التغير وقد
أثبتناهما ولكنه وضع لنفسه اصطلاحاً في أحكام المعاني القائمة بالغير وميز
بين حكم العلم والقدرة وهي العالمية والقادرية والمريدية وبين حكم الحركة
والسكون القائمين بالجوهر وهو المتحركية والساكنية فإن كان هذا التميز غير
مقبول عقلاً فإن اتصاف المحال بالأوصاف الحادثة واتصاف الذات بالأوصاف من
حيث أنها صفات وموصوفات ليس تختلف ولا تأثير للقدم والحدوث فيها أصلاً
فإنه إن كان الوصف راجعاً إلى القول واللسان فلا يختلف الحال بين وصف ووصف
وإن كان الوصف راجعاً إلى حقيقة في الموصوف يعبر عنها لسان الواصف فلا
يختلف الحال بين حقيقة وحقيقة والمعنى إذا قام بذات أو محل صار وصفاً
وصفةً لها ورجع حكمه إليه بالضرورة.
برهان آخر أوضح مما قد سبق وهو أن
كل حادث يحتاج إلى محدث من حيث أنه كان في نفسه وباعتبار ذاته جائز الوجود
والعدم فلما ترجح جانب الوجود على العدم احتاج إلى مرجح بالضرورة ثم ذلك
المرجح إن كان حادثاً احتاج إلى مرجح ثم يتسلسل القول فيه إلى ما لانهاية
له وجهة الاحتياج لا يختلف الحال فيها بين حادث في ذاته سبحانه وتعالى
وبين محدث مباين ذاته فإنه إنما احتاج بجهة تردده بين طرفي جواز الوجود
والعدم لا بجهة التباين وغير التباين وهذا قاطع لا اعتراض عليه.
ونقول إن تصور وجود حادث لا بإحداث فإما أن يقال يحدث ذلك الحادث بنفسه أو
بقدرته أو بمشيئته قديمة.
فإن قيل يحدث بنفسه فقد باهتوا العقل الصريح بضرورة حكمه بأن ما لم يكن
فكان احتاج إلى محدث مكون.
فإن
قيل أحدث بقدرة ومشيئة فقد ناقضوا قضية العقل فإن ذلك الحادث إذا جاز أن
يحدث بالقدرة فلم لا يجوز أن يحدث المحدثات كلها بقدرته ومشيئته إذ لا فرق
في نظر العقل بين الحادث والمحدث من حيث أنه لم يكن فكان.
والفرق
بينهما من حيث اللغة أن أحدهما لازم والثاني متعد لا ينتهض فرق من حيث
العقل فإنا إذا قلنا قام وقعد وجاء وذهب كان الحكم لازماً والقيام والقعود
والمجي والذهاب فعله ومفعوله كما هو فعله والعقل لا يفرق بين فعل الإنسان
شيئاً في نفسه وبين فعله في غيره على مذهب من قال به ومن قال أن الفعل لا
يباين محل القدرة فلم يفرق فيه بين الفعل والمفعول ولا متمسك للخصم في هذه
المسئلة إلا بأمر لغوي ولفظ اصطلاحي.
وقد ألزم عليه الفلسفي إلزاماً لا
محيص له عنه فقال كل ذات لم يحدث فيها معنىً ثم حدث فيها قبل الحدوث
استعداد القبول وصلاحيته وقوته ثم إذا حدث فيها القبول تبدل الاستعداد
بالوجود والصلاحية بالحصول والقوة بالفعل ويلزم أن يكون في ذاته معنى ما
بالقوة ثم معنى ما بالفعل وذلك بعينه هو الهيولي والصورة وقد أثبتوا لله
سبحانه وتعالى قبل خلق العالم خصائص الهيولي وهي طبائع عدمية فإن
الاستعداد والصلاحية عدم شيء من إثباته أن يكون شيئاً وواجب الوجود لذاته
منزه عن طبيعة الإمكان والعدم اللذان هما منبع الشر.
وأما طرق الإلزام
عليهم فمنها أن قالوا قول الله سبحانه وتعالى وإرادته من جنس قولنا
وإرادتنا ثم لقوله وإرادته مفعولات مثل العالم بما فيه من السموات والأرض
فيلزم أن يحصل بإرادتنا وقولنا مثل ذلك فإن قوله كن كاف ونون من جنس
أقوالنا من غير فرق.
فإن قيل إنما حصل قوله بمباشرة قدرته وإرادته
ومشيئته القديمة وقولنا لم يحصل بهما وقوله في ذاته قول له لا لغيره وقد
قصد به التكوين لا بغيره.
قيل له إن كان هذا فرقاً فلم يكن قوله إذاً
من جنس أقوالنا بل الحق أن القول إذا حدث بعد أن لم يكن فهو كقولنا الحادث
بعد أن لم يكن ولم يكن لإضافته إلى القدرة أثر بعد الحدوث فإنه إنما أثر
في حال الانفصال عن القدرة لا في حال تعلق القدرة به وإنما أثرت القدرة في
حصول ذاته فقط لا في شيء آخر يحدث به وعن هذا لو أحدث قولاً لنفسه في شجرة
وقصد به التكوين لم يحصل به شيء فبطل قولهم إنما قصد به الأحداث وبطل ما
اعتذروا به وحصل أن قوله لا ينبغي أن يوجد كقولنا أو قولنا يوجد كقوله إذ
لا فرق بين قول وقول في الحدوث والحروف والأصوات والاحتياج إلى المحل بل
قولنا أو كد فإنه إذا قام بمحل اتصف المحل به وتحققت له النسبة إلى المحل
وعندكم قول الله سبحانه قائم به من غير أن تتصف به الذات ولم تتحقق له
نسبة إلى الذات إلا مجرد الإضافة وقد انقطع حكمه عن القدرة القديمة فإنه
إنما يوجد بعد أن يحدث لا حال أن يحدث.
ومن الإلزامات أن قوله كن لا
يخلو إما أن يسبق أحد الحرفين على الثاني أو يتلازمان في الوجود إما في
حال الوجود أو حال البقا فإن سبق أحدهما وتلاه الثاني فأما أن يبقى الأول
أو لم يبق فإن بقي مقولاً مسموعاً لم يكن كن بل الأول ما لم ينعدم لا يوجد
الثاني حتى يكون مترتباً متعاقباً وإلا فالكاف المسموع مع النون دواماً لا
يتصور أصلاً وإن لم يبق فقد انعدم وعندكم ما حل في ذاته تعالى لا يجوز
عليه العدم وإن كانا يتلازمان في الوجود فقد أوجد أحدهما مع الثاني فليس
الكاف بالتقديم أولى من النون وكذلك كل حرف يجب أن يسبق حرفاً في القول
والتكلم حتى يكون بترتبه وتعاقبه كلاماً مسموعاً.
ومن الإلزامات إثبات
أكوان حادثة مع الكون القديم وإثبات علوم حادثة مع العلم القديم كإثبات
إرادة حادثة مع المشيئة القديمة وقد ذكر المتكلمون ذلك في كتبهم.
أما شبهة الكرامية أن قالوا سمع الباري سبحانه ما لم يسمع قبله ورأى ما لم
ير قبله فيجب أن يحدث له تسمع وتبصر.
فقيل
لهم أتقولون لم يكن الباري سبحانه سامعاً للأصوات فصار سامعاً لها ولا
رائياً للمدركات فصار رائياً لها ولم يكن قائلاً للأوامر والنواهي فصار
قائلاً ولم يرد وجود العالم في الوقت الذي سبق وجوده فصار مريداً في الوقت
الذي أوجده فيدل كل ذلك على تجدد وصف له وإن لم تقولوا أنه صار سميعاً
بصيراً مريداً فقد تناقض قولكم أنه سمع ما لم يسمع ورأى ما لم ير وأراد ما
لم يرد.
ثم الجواب الحقيقي قلنا قد جمعتم بين كلمتي نفي وإثبات في
قولكم لم يكن كذا فصار كذا فلا النفي على أصلنا مسلم ولا الإثبات على
أصلكم مذهب لكم فأما النفي على أصلنا فغير مسلم أنه لم يكن سميعاً بصيراً
بل هو بصير سميع أبداً وأزلاً كما هو عليم قدير أبداً وأزلاً وإنما التجدد
يرجع إلى المدرك كما يرجع التجدد إلى المعلوم والمقدور فهو كقولكم لم يكن
مستوياً على العرش فصار مستويا ولم يكن بجهة فوق فصار بجهة فوق وبالاتفاق
لم تحدث له صفة لم تكن بل النفي إنما يرجع إلى المدركات فنقول لم تكن
المسموعات والمرئيات موجودة فيسمع ويرى فوجدت فتعلق بها السمع والبصر فكان
التعلق مشروطاً بالوجود لا بالمتعلق ورب تعلق شرط فيه الوجود والحياة
والعقل والبلوغ ثم عدم الشرط لم يقتض عدم المتعلق.
أما الإثبات فعلى
أصلكم لم يوصف الباري سبحانه بالحوادث في ذاته فكيف يصح على مذهبكم أنه
صار سميعاً بصيراً وإن التزمتم الاتصاف فقد سلمتم لنا المسئلة فإن الاتصاف
بصفة لم يكن قبل صريح التغيير والتغيير دليل الحدوث وهذه الحوادث باقيات
على مذهبكم والمتعلقات فانية وإثبات صفة من الصفات المتعلقة يتأخر تعلقها
أو متعلقها غير مستحيل كالعلم والقدرة والمشيئة أما إثبات صفة باقية يتقدم
تعلقها أو متعلقها فهو مستحيل فإنه إذا أراد وجود العالم بإرادة حادثة في
ذاته ووجد العالم وبقي وفني فهو مريد أبد الدهر وقائل كن أبد الدهر لشيء
قد تكون وفني وسامع لصوت وحرف قد مضى وانقضى وبصير لجسم ولون قد انقرض في
غاية الاستحالة.
ونقول هذه الحروف التي أثبتموها هي حروف مجردة من غير
أصوات أم هي حروف هي تقطيع أصوات فإن أثبتموها حروفاً من غير أصوات فهي
غير مسموعة ولا هي معقولة فإن حقيقة الحرف تقطيع صوت والصوت بالنسبة إلى
الحروف كالجنس بالنسبة إلى النوع والعرض بالنسبة إلى اللون فإن أثبتوا
حروفاً هي أصوات مقطعة فلا بد لها من اصطكاكات أجرام حتى يتحقق الصوت فإن
اصطكاك الأجرام كالنوع بالنسبة إلى الحركة والصوت كالنوع بالنسبة إلى
الاصطكاك ولا بد من حركة حتى يتحقق اصطكاك أو تفكيك ولا بد من اصطكاك حتى
يتحقق الصوت ولا بد من صوت حتى يتحقق حرف ولا بد من حرف حتى تتحقق كلمة
ولا بد من كلمة حتى يتحقق قول تام ولا بد من قول حتى تتحقق قصة وحكاية
فيلزم على ذلك أن يكون الباري جسماً متحركاً ذا اصطكاك في أجزاء جسمية
ويتعالى الرب سبحانه عن ذلك علواً كبيراً.
وقد تخطى بعض الكرامية إلى
إثبات الجسمية فقال أعني بها القيام بالنفس وذلك تلبيس على العقلاء وإلا
فمذهب أستاذهم مع اعتقاد كونه محلاً للحوادث قائلاً بالأصوات مستوياً على
العرش استقراراً مختصاً بجهة فوق مكاناً واستعلاءً فليس ينجيه من هذه
المخازي تزويرات ابن هيصم فليس يريد بالجسمية القائم بالنفس ولا بالجهة
الفوقية علاءً ولا بالاستواء استيلاءً وإنما هو إصلاح مذهب لا يقبل
الإصلاح وإبرام معتقد لا يقبل الإبرام والإحكام وكيف استوى الظل والعود
اعوج وكيف استوى المذهب وصاحب المقالة أهوج والله الموفق.
القاعدة الخامسة
في إبطال مذهب التعطيل وبيان وجوه التعطيل
وقد قيل أن التعطيل ينصرف إلى وجوه شتى فمنها تعطيل الصنع عن الصانع ومنها تعطيل الصانع عن الصنع ومنها تعطيل الباري سبحانه عن الصفات الأزلية الذاتية القائمة بذاته ومنها تعطيل الباري سبحانه عن الصفات والأسماء أزلاً ومنها تعطيل ظواهر الكتاب والسنة عن المعاني التي دلت عليها.أما
تعطيل العالم عن الصانع العالم القادر الحكيم فلست أراها مقالة لأحد ولا
أعرف عليه صاحب مقالة إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية أنهم قالوا
العالم كان في الأزل أجزاء مبثوثة تتحرك على غير استقامة واصطكت اتفاقاً
فحصل عنها العالم بشكله الذي تراه عليه ودارت الأكوار وكرت الأدوار وحدثت
المركبات ولست أرى صاحب هذه المقالة ممن ينكر الصانع بل هو معترف بالصانع
لكنه يحيل سبب وجود العالم على البحث والاتفاق احترازاً عن التعليل فما
عددت هذه المسئلة من النظريات التي يقام عليها برهان فإن الفطرة السليمة
الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على صانع حكيم عالم قدير "
أفي الله شك فاطر السموات والأرض ولئن سألهم من خلقكم ليقولن الله ولئن
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم " وإن هم غفلوا
عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم يلوذون إليه في حال الضراء "
دعوا الله مخلصين له الدين وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه
" ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي
الشريك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ولهذا جعل محل
النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد " ذلك بأنه إذا دعي الله وحده
كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا " الآية " وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين
لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً
" وقد سلك المتكلمون طريقين في إثبات الصانع تعالى وهو الاستدلال بالحوادث
على محدث صانع وسلك الأوائل طريقاً آخر وهو الاستدلال بإمكان الممكنات على
مرجح لأحد طرفي الإمكان ويدعى كل واحد في جهة الاستدلال ضرورة وبديهة.
وأنا
أقول ما شهد به الحدوث أو دل عليه الإمكان بعد تقديم المقدمات دون ما شهدت
به الفطرة الإنسانية من احتياج في ذاته إلى مدبر هو منتهى الحاجات فيرغب
إليه ولا يرغب عنه ويستغني به ولا يستغني عنه ويتوجه إليه ولا يعرض عنه
ويفزع إليه في الشدائد والمهمات فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن
الخارج إلى الواجب والحادث إلى المحدث وعن هذا كانت تعريفاته الخلق سبحانه
في هذا التنزيل على هذا المنهاج أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن ينجيكم من
ظلمات البر أمن يرزقكم من السماء والأرض أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وعن هذا
قال النبي صلى الله عليه وسلم " خلق الله تعالى الخلق على معرفته فاحتالهم
الشيطان عنها " فتلك المعرفة هي ضرورة الاحتياج وذلك الاحتيال من الشياطين
هو تسويله الاستغناء ونفي الاحتياج والرسل مبعوثون لتذكير وضع الفطرة
وتطهيرها عن تسويل الشيطان فإنهم الباقون على أصل الفطرة " وما كان له
عليهم من سلطان " وقال " فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى " وقوله "
فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى " ومن رحل إلى الله قربت مسافته
حيث رجع إلى نفسه أدنى رجوع فعرف احتياجه إليه في تكوينه وبقائه وتقلبه في
أحواله وأنحائه ثم استبصر في آيات الآفاق إلى آيات الأنفس ثم استشهد به
على الملكوت لا بالملكوت عليه " أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد "
عرفت الأشياء بربي وما عرفت ربي بالأشياء ومن غرق في بحر المعرفة لم يطمع
في شط ومن تعالى إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط فثبت بالدلائل والشواهد أن
العالم لا يتعطل عن الصانع الحكيم القادر العليم سبحانه وتقدس.
وأما
تعطيل الصانع عن الصنع فقد ذهب وهم الدهرية القائلين بقدم العالم إلى أن
الحكم بقدم العالم في الأزل تعطيل الصانع عن الصنع وقد سبق الرد عليهم بأن
الإيجاد قد تحقق حيث تصور الإيجاد وحيث ما لم يتصور لم يكن تعطيلاً وكما
أن التعطيل ممتنع كذلك التعليل ممتنع وأنتم عللتم وجود العالم بوجوده
وسميتم معبودكم علة ومبداً وموجباً وذلك يودي إلى أمرين محالين أحدهما
بثبوت المناسبة بين العلة والمعلول وقد سبق تقريره والثاني أن العلة توجب
معلولها لذاتها والقصد الأول وجود العالم من لوازم وجوده بالقصد الأول فإن
العالي لا يريد أمراً لأجل الأسفل فبطل أيضاً التعليل وهذا من الإلزامات
المفحمة التي لا جواب عنها.
أما تعطيل الباري سبحانه عن الصفات
الذاتية والمعنوية وعن الأسماء والأحكام فذلك مذهب الإلهيين من الفلاسفة
فإنهم قالوا واجب الوجود لذاته واحد من كل وجه فلا يجوز أن يكون لذاته
مبادئ تجتمع فيتقدم واجب الوجود لا أجزاء كمية ولا أجزاء حد سواء كانت
كالمادة والصورة أو كانت على وجه آخر بأن يكون أجزاء لقول الشارح لمعنى
اسمه ويدل كل واحد منهما على شيء هو في الوجود غير الآخر بذاته وذلك لأن
ما هذا صفته فذات كل واحد منه ليس ذات الآخر ولا ذات المجتمع وإنما تعينه
واجب بالذات فليس يقتضي معنى آخر سوى وجوده وإن وصف بصفة فليس يقتضي ذلك
معنى غير ذاته واعتباراً ووجهاً غير وجوده بل الصفات كلها إما إضافية
كقولنا مبدأ العالم وعلة العقل كما تقولون خالق ورازق وأما سلبية كقولنا
واحد أي ليس بمتكثر وعقل أي مجرد عن المادة وقد يكون تركيبه من إضافة وسلب
كقولنا حكيم مريد وسيأتي شرح ذلك في كتاب الصفات فألزم عليهم مناقضات.
منها
أنهم أطلقوا لفظ الوجود على الواجب بذاته وعلى الواجب لغيره شمولاً
وعموماً على سبيل الاشتراك ثم خصصوا أحد الوجودين الوجوب والثاني بالجواز
ومن المعلوم أن الوجوب لم يدخل في معنى لوجود حتى يتصور الوجود فهذا إذاً
معنى آخر وراء الوجود والمعنيان أن اتحدا في الخارج من الذهن فقد تمايزا
في العقل مثل العرضية واللونية وليس يغني عن هذا الإلزام قولهم إطلاق لفظ
الوجوب على الواجب بذاته والجائز لذاته بالتشكيك أي هو في أحدهما أولى
وأول وفي الثاني لا أولى ولا أول إذ الأولى والأول فصل آخر تميز به أحد
الوجودين عن الثاني وذلك يؤكد الإلزام ولا يدفعه.
ومن الإلزامات كونه
مبدأ وعلة وعاقلاً ومعقولاً فإن اعتبار كونه واجب الوجود لذاته لا يفيد
اعتبار كونه مبدأ وعلة واعتبار كونه مبدأ وعلة لا يفيد اعتبار كونه عقلاً
وعاقلاً ومعقولاً فإن ساغ لكم الحكم بتكثير الاعتبارات ساغ للمتكلم إثبات
الصفات وتعطيله عن الصفات تعطيل عن الاعتبارات وأما الباري عن الصفات
والأسماء والأحكام أزلاً وأبداً وما صار إليه صائر إلا شرذمة من قدماء
الحكماء قالوا إن المبدع الأول آنية أزلية وهو قبل الإبداع عديم الاسم
فلسنا ندرك له اسماً في نحو ذاته وإنما أسماؤه من نحو آثاره وأفاعيله
وأبدع الذي أبدع ولا صورة له عنده في الذات أي لا علم ولا معلوم وإنما
العلم والمعلوم في المعلول الأول الذي هو العنصر فهم المعطلة حقاً ونقل عن
بعض الحكماء أنهم قالوا هو هو ولا نقول موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل
ولا قادر ولا عاجز ولا مريد ولا كاره ولا متكلم ولا ساكت وكذلك سائر
الأسماء والصفات وينسب هذا المذهب إلى الغالية من الشيعة والباطنية ولا شك
أن من أثبت صانعاً لم يكن له بد من عبارة عنه وذكر اسم له ثم الاشتراك في
الأساسي ليس يوجب اشتراكاً في المعاني فهاؤلاء احترزوا عن إطلاق لفظ
الوجود عليه وما أشبهه من الأسماء لأحد أمرين أحدهما لاعتقادهم أن
الاشتراك في الاسم يوجب اشتراكاً في المعنى فيتحقق له مثل ذلك الوجه
والثاني لاعتقادهم أن كل اسم من الأسامي التي تطلق عليه يقابله اسم آخر
تقابل التضاد مثل الموجود يقابله المعدوم والعالم يقابله الجاهل والقادر
يقابله العاجز فيتحقق له ضد من ذلك الوجه فاحترزوا عن إطلاق لفظ وجودي أو
عدمي لكيلا يقعوا في التمثيل والتعطيل ونحن نعلم بأن الأسامي المشتركة هي
التي تختلف حقائقها من حيث المعاني فإن اسما الباري تبارك وتعالى إنما
تتلقى من السمع وقد ورد السمع أنه سبحانه عليم قدير حي قيوم سميع بصير
لطيف خبير وأمرنا أن ندعوه عز وجل بأحسن الأسمين المتقابلين كما قال
تعالى: " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه
سيجزون ما كانوا يعملون " ولم يحترز هذا الاحتراز البارد ولا تكلف هذا
التكلف الشارد.
وقالت طائفة من الشيعة لا يجوز التعطيل من الأسماء
الحسنى ولا يجوز التشبيه بالصفات التي يشترك فيها الخلق فيطلق على الباري
سبحانه الوجود وندعوه بأحسن الأسماء وهو العليم القدير السميع البصير إلى
غير ذلك مما ورد في التنزيل لكن لا بمعنى الوصف والصفة لأن علياً عليه
السلام كان يقول في توحيده لا يوصف بوصف ولا يحد بحد ولا يقدر بمقدار الذي
كيف الكيف لا يقال له كيف والذي أين الأين لا يقال له أين لكنا نطلق
الأسماء بمعنى الإعطاء فهو موجود بمعنى أنه يعطي الوجود وقادر وعالم بمعنى
أنه واهب العلم للعالمين والقدرة للقادرين حي بمعنى أنه يحيي الموتى قيوم
بمعنى أنه يقيم العالم سميع بصير أي خالق السمع والبصر ولا نقول أنه عالم
لذاته أو يعلم بل هو إله العالمين بالذات والعالمين بالعلم وعلى هذا
المنهاج يسلكون في إطلاق الأسامي وكذلك الواحد والعليم والقدير وينسب إلى
محمد بن علي الباقر أنه قال هل سمي عالماً إلا أنه واهب العلم للعالمين
وهل سمي قادراً إلا لأنه واهب القدرة للقادرين وليس هذا قولاً بالتعطيل
فإنه لم يمنع من إطلاق الأسامي والصفات كمن امتنع وقال ليس بمعدوم ولا
موجود ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولكنه استدل بالقدرة في
القادرين على أنه قادر وبالعلم في العالمين على أنه عالم وبالحياة في
الأحياء على أنه حي قيوم واقتصر على ذلك من غير خوض في الصفات بأنها لذاته
أو لمعاني قائمة بذاته كيلا يكون متصرفاً في جلاله بفكره العقلي وخياله
الوهمي وقد اجتمع السلف بل الأمة على أن ما دار في الوهم أو خطر في الخيال
والفهم فالله سبحانه خالقه ومبدعه ولا محمل لقول علي صلوات الله عليه
وسلامه لا يوصف بوصف إلا هذا الذي ذكرناه.
القاعدة السادسة
في الأحوال
اعلم أن المتكلمين قد اختلفوا في الأحوال نفياً وإثباتاً بعد أن أحدث أبو هاشم بن الجباي رأيه فيها وما كانت المسئلة مذكورة قبله أصلاً فأثبتها أبو هاشم ونفاها أبوه الجباي وأثبتها القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله بعد ترديد الرأي فيها على قاعدة غير ما ذهب إليه ونفاها صاحب مذهبه الشيخ أبو الحسن الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم وكان إمام الحرمين من المثبتين في الأول والنافين في الآخر والأحرى بنا أن نبين أولاً ما الحال التي توارد عليها النفي والإثبات وما مذهب المثبتين فيها وما مذهب النافين ثم نتكلم في أدلة الفريقين ونشير إلى مصدر القولين وصوابهما من وجه وخطأيهما من وجه.أما بيان الحال وما هو أعلم أنه ليس للحال حد حقيقي يذكر حتى نعرفها بحدها وحقيقتها على وجه يشمل جميع الأحوال فإنه يودي إلى إثبات الحال للحال بل لها ضابط وحاصر بالقسمة وهي تنقسم إلى ما يعلل وإلى ما لا يعلل وما يعلل فهي أحكام لمعان قائمة بذوات وما لا يعلل فهو صفات ليس أحكاماً للمعاني.
أما
الأول فكل حكم لعلة قامت بذات يشترط في ثبوتها الحياة عند أبي هاشم ككون
الحي حياً عالماً قادراً مريداً سميعاً بصيراً لأن كونه حياً عالماً يعلل
بالحياة والعلم في الشاهد فتقوم الحياة بمحل وتوجب كون المحل حياً وكذلك
العلم والقدرة والإرادة وكل ما يشترط في ثبوته الحياة وتسمى هذه الأحكام
أحوالاً وهي صفات زائدة على المعاني التي أوجبتها وعند القاضي رحمه الله
كل صفة لموجود لا تتصف بالوجود فهي حال سواء كان المعنى الموجب مما يشترط
في ثبوته الحياة أو لم يشترط ككون الحي حياً وعالماً وقادراً وكون المتحرك
متحركاً والساكن ساكناً والأسود والأبيض إلى غير ذلك ولابن الجباي في
المتحرك اختلاف رأي وربما يطرد ذلك في الأكوان كلها ولما كانت البنية عنده
شرطاً في المعاني التي تشترط في ثبوتها الحياة وكانت البنية في أجزائها في
حكم محل واحد فتوصف بالحال وعند القاضي أبي بكر رحمه الله لا يوصف بالحال
إلا الجزء الذي قام به المعنى فقط وأما القسم الثاني فهو كل صفة إثبات
لذات من غير علة زائدة على الذات كتحيز الجوهر وكونه موجوداً وكون العرض
عرضاً ولوناً وسواداً والضابط أن كل موجود له خاصية يتميز بها عن غيره
فإنما يتميز بخاصية هي حال وما تتماثل المتماثلات به وتختلف المختلفات فيه
فهو حال وهي التي تسمى صفات الأجناس والأنواع والأحوال عند المثبتين ليست
موجودة ولا معدومة ولا هي أشياء ولا توصف بصفة ما وعند ابن الجباي ليست هي
معلومة على حيالها وإنما تعلم مع الذات وأما نفاة الأحوال فعندهم الأشياء
تختلف وتتماثل لذواتها المعينة وأما أسماء الأجناس والأنواع فيرجع عمومها
إلى الألفاظ الدالة عليها فقط وكذلك خصوصها وقد يعلم الشيء من وجه ويجهل
من وجه والوجوه اعتبارات لا ترجع إلى صفات هي أحوال تختص بالذوات وهذا
تقرير مذهب الفريقين في تعريف الحال.
أما أدلة الفريقين فقال المثبتون
العقل يقضي ضرورة أن السواد والبياض يشتركان في قضية وهي اللونية والعرضية
ويفترقان في قضية وهي السوادية والبياضية فما به الاشتراك غير ما به
الافتراق أو غيره فالأول سفسطة والثاني تسليم المسئلة.
وقال النفاة
السواد والبياض المعنيان قط لا يشتركان في شيء هو كالصفة لهما بل يشتركان
في شيء هو اللفظ الدال على الجنسية والنوعية والعموم والاشتراك فيه ليس
يرجع إلى صفة هي حال للسواد والبياض فإن حالتي العرضين يشتركان في الحالية
ولا يقتضي ذلك الاشتراك ثوب حال للحال فإنه يؤدي إلى التسلسل فالعموم
كالعموم والخصوص كالخصوص.
قال المثبتون الاشتراك والافتراق قضية عقلية
وراء اللفظ وإنما صيغ اللفظ على وفق ذلك ومطابقته ونحن إنما تمسكنا
بالقضايا العقلية دون الألفاظ الوضعية ومن اعتقد أن العموم والخصوص يرجعان
إلى اللفظ المجرد فقد أنكر الحدود العقلية للأشياء والأدلة القطعية على
المدلولات والأشياء لو كانت تتمايز بذواتها ووجودها بطل القول بالقضايا
العقلية وحسم باب الاستدلال بشيء أولى على شيء مكتسب متحصل وما لم يدرج في
الأدلة العقلية عموماً عقلياً لم يصل إلى العلم بالمدلول قط وما لم يتحقق
في الحد شمولاً بجميع المحدودات لم يصل إلى العلم المحدود.
قال النافون
الكلام على المذهب رداً وقبولاً إنما يصح بعد كون المذهب معقولاً ونحن
نعلم بالبديهة أن لا واسطة بين النفي والإثبات ولا بين العدم والوجود
وأنتم اعتقدتم الحال لا موجودة ولا معدومة وهو متناقض بالبديهة ثم فرقتم
بين الوجود والثبوت فأطلقتم لفظ الثبوت على الحال ومنعتم إطلاق لفظ الوجود
فنفس المذهب إذاً لم يكن معقولاً فكيف يسوغ سماع الكلام والدليل عليه.
ومن
العجائب أن ابن الجباي قال لا توصف بكونها معلومة أو مجهولة وغاية
الاستدلال إثبات العلم بوجود الشيء فإذا لم يتصور له وجود ولا تعلق العلم
به بطل الاستدلال عليه وتناقض الكلام فيه.
ثم قالوا ما المعنى
بقولكم الافتراق والاشتراك قضية عقلية إن عنيتم به أن الشيء الواحد يعلم
من وجه ويجهل من وجه فالوجوه العقلية اعتبارات ذهنية وتقديرية ولا يقتضي
ذلك صفات ثابتة لذوات وذلك كالنسب والإضافات مثل القرب والبعد في الجوهرين
فإن عنيتم بذلك أن الشيء الواحد تتحقق له صفة يشارك فيها غيره وصفة يمايز
بها غيره فهو نفس المتنازع فيه فإن الشيء الواحد المعين لا شركة فيه بوجه
والشيء المشترك العام لا وجود له البتة.
وقولهم إن نفي الحال يؤدي إلى
حسم باب الحد والحقيقة والنظر والاستدلال بالعكس أولي فإن إثبات الحال
التي لا توصف بالوجود والعدم وتوصف بالثبوت دون الوجود حسم باب الحد
والاستدلال فإن غاية الناظر أن يأتي في نظره بتقسيم دائر بين النفي
والإثبات فينفي أحدهما حتى يتعين الثاني ومثبت الحال قد أتى بواسطة بين
الوجود والعدم فلم يفد التقسيم والإبطال علماً ولا يتضمن النظر حصول معرفة
أصلاً ثم الحد والحقيقة على أصل نفاة الأحوال عبارتان عن معبر واحد فحد
الشيء حقيقته وحقيقته ما اختص في ذاته عن سائر الأشياء ولكل شيء خاصية بها
يتميز عن غيره وخاصيته تلزم ذاته ولا تفارقه ولا يشترك فيها بوجه وإلا بطل
الاختصاص وأما العموم والخصوص في الاستدلال فقد بينا أنه راجع إلى الأقوال
الموضوعة لها ليربط شكلاً بشكل ونظيراً بنظير والذات لا تشتمل على عموم
وخصوص البتة بل وجود الشيء وأخص وصفه واحد.
قال المثبتون نحن لم نثبت
واسطة بين النفي والإثبات فإن الحال ثابته عندنا ولولا ذلك لما تكلمنا
فيها بالنفي والإثبات ولم نقل على الإطلاق أنه شيء ثابت على حياله موجود
فإن الموجود المحدث إما جوهر وإما عرض وهو ليس أحدهما بل هو صفة معقولة
لهما فإن الجوهر قد يعلم بجوهريته ولا يعلم بحيزه وكونه قابلاً للعرض
والعرض يعلم بعرضيته ولا يخطر بالبال كونه لوناً أو كوناً ثم يعرف كونه
لوناً بعد ذلك ولا يعرف كونه سواداً أو بياضاً إلا أن يعرف والمعلومان إذا
تمايزا في الشيء الواحد رجع التمايز إلى الحال وقد يعلم ضرورة من وجه
ويعلم نظراً من وجه كمن يعلم كون المتحرك متحركاً ضرورة ثم يعلم بالنظر
بعد ذلك كونه متحركاً بحركة ولو كان المعنيان واحداً لما علم أحدهما
بالضرورة والثاني بالنظر ولما سبق أحدهما إلى العقل وتأخر الآخر ومن أنكر
هذا فقد جحد الضرورة ونفاة الأعراض أنكروا أن الحركة عرضاً زائداً على
المتحرك وما أنكروا كونه متحركاً وأنتم معاشر النفاة وافقتمونا على أن
الحركة علة لكون الجوهر متحركاً وكذلك القدرة والعلم وجميع الأعراض
والمعاني والعلة توجب المعلول لا محالة فلا يخلو إما أن توجب ذاتها وإما
شيئاً آخر وراء ذاتها ويستحيل أن يقال توجب ذاتها فإن الشيء الواحد من وجه
واحد يستحيل أن يكون موجباً وموجباً لنفسه وإن أوجب أمراً آخرا فذلك الأمر
إما ذات على حيالها أو صفة لذات ويستحيل أن تكون ذاتاً على حيالها فإنه
يؤدي إلى أن تكون العلة بإيجابها موجدة للذوات وتلك الذوات أيضاً علل وهو
محال فإنه يؤدي إلى التسلسل فيتعين أنه صفة لذات وذلك هو الحال التي
أثبتناها فالقسمة العقلية ألجأتنا إلى إثباتها والضرورة حملتنا على أن لا
نسميها موجودة على حيالها ومعلومة على حيالها وقد يعلم الشيء مع غيره ولا
يعلم على حياله كالتأليف بين الجوهرين والمماسة والقرب والبعد فإن الجوهر
الواحد لا يعلم فيه تأليف ولا مماسة ما لم ينضم إليه جوهر آخر وهذا في
الصفات التي هي ذوات وأعراض متصور فكيف في الصفات التي ليست بذوات بل هي
أحكام الذوات.
وأما قولكم أنه راجع إلى وجوه واعتبارات عقلية فنقول هذه
الوجوه والاعتبارات ليست مطلقة مرسلة بل هي مختصة بذوات فالوجوه العقلية
لذات واحدة هي بعينها الأحوال فإن تلك الوجوه ليست ألفاظاً مجردة قائمة
بالمتكلم بل هي حقائق معلومة معقولة لا أنها موجودة على حيالها ولا معلومة
بانفرادها بل هي صفات توصف بها الذوات فما عبرتم عنه بالوجوه عبرنا عنه
بالأحوال فإن المعلومين قد تمايزا وإن كانت الذات متحدة وتمايز المعلومين
يدل على تعدد الوجهين والحالين وذلك معلومان محققان تعلق بهما علمان
متمايزان أحدهما ضروري والثاني مكتسب وليس ذلك كالنسب والإضافات فإنها
ترجع إلى ألفاظ مجردة ليس فيها علم محقق متعلق بمعلوم محقق.
وقولهم
الشيء الواحد لا شركة فيه والمشترك لا وجود له باطل فإن الشيء المعين من
حيث هو معين لا شركة فيه وهذه الصفات التي أثبتناها ليست معينة مخصصة بل
هي صفات يقع بها التخصيص والتعيين ويقع فيها الشمول والعموم وهو من
القضايا الضرورية كالوجوه عندكم ومن رد التعميم والتخصيص إلى مجرد الألفاظ
فقد أبطل الوجوه والاعتبارات العقلية أليست العبارات تتبدل لغة فلغة وحالة
فحالة وهذه الوجوه العقلية لا تتبدل بل الذوات ثابتة عليها قبل التعبير
عنها بلفظ عام وخاص على السواء ومن ردها إلى الاعتبارات فقد ناقض وردها
إلى العبارات فإن الاعتبارات لا تتبدل ولا تتغير بعقل وعقل والعبارات
تتبدل بلسان ولسان وزمان وزمان.
وقولهم حد الشيء وحقيقته وذاته عبارات عن معبر واحد والأشياء إنما تتميز
بخواص ذواتها ولا شركة في الخواص.
قال
المثبت هب أن الأمر كذلك لكن خاصية كل شيء معين غير وخاصية كل نوع محقق
غير وأنتم لا تحدون جوهراً بعينه على الخصوص بل تحدون الجوهر من حيث هو
جوهر على الإطلاق فقد أثبتم معنى عاماً يعم الجواهر وهو التحيز مثلاً وإلا
لكان كل جوهر على حالة محتاجاً إلى حد على حياله ولا يجوز أن يجري حكم
جوهر في جوهر من التحيز وقبول الأعراض والقيام بالنفس فإذاً لم نجد بداً
من أدراج أمر عام في الحد وذلك يبطل قولكم أن الأشياء إنما تتمايز بذواتها
ويصح قولنا أن الحدود لا تستغني عن عمومات ألفاظ تدل على صفات عموم الذوات
وصفات خصوص وتلك أحوال لها ووجوه واعتبارات عقلية أو ما شئت فسمها بعد
الاتفاق على المعاني والحقائق.
قال النافون غاية تقريركم في إثبات
الحال هو التمسك بعمومات وخصوصات ووجوه عقلية واعتبارات أما العموم
والخصوص فمنتقض عليكم بنفس الحال فإن لفظ الحال يشمل جنس الأحوال وحال هي
صفة لشيء تخص ذلك الشيء لا محالة فلا يخلو إما أن يرجع معناه إلى عبارة
تعم وعبارة تخص فخذوا منا في سائر العبارات العامة والخاصة كذلك وإما أن
ترجع إلى معنى آخر وراء العبارة فيؤدي إلى إثبات الحال للحال وذلك محال
ولا يغني عن هذا الإلزام قولكم الصفة لا توصف فإنكم أول من أثبت للصفة صفة
حيث جعلتم الوجود والعرضية واللونية والسوادية أحوالاً للسواد فإذا أثبتم
للصفات صفات فهلا أثبتم للأحوال أحوالاً وأما الوجوه والاعتبارات فقد
تتحقق في الأحوال أيضاً فإن الحال العام غير والحال الخاص غير وهما
اعتباران في الحال وحال يوجب أحوالاً غير وحال هي موجبة الحال غير أليس قد
أثبت أبو هاشم حالاً للباري سبحانه توجب كونه عالماً قادراً والعالمية
والقادرية حالتان فحال توجب وحال هي غير موجبة مختلفتان في الاعتبار
واختلاف الاعتبارين لا يوجب اختلاف الحالين للحال.
هذا من الإلزامات
المفحمة ومن جملتها أخرى وهي أن الوجود في القديم والحادث والجوهر والعرض
عندهم حال لا يختلف البتة بل وجود الجوهر في حكم وجود العرض على السواء
فيلزمهم على ذلك أمران منكران إبهام شيء واحد في شيئين مختلفين أو شيئان
مختلفان في شيء واحد وواحد في اثنين واثنان في واحد محال أما أحدهما أن
شيئاً واحداً كيف يتصور في شيئين فإن حال الوجود من حيث هو وجود واحد ومن
بدايه العقول أن الشيء الواحد لا يكون في شيئين مهاً بل في جميع الموجودات
على السواء وفي ما لم يوجد بعد لكنه سيوجد على السواء وهو من أمحل المحال.
والمنكر
الثاني إذا كان الوجود حالاً واحداً واجتمعت فيه أجناس وأنواع وأصناف
فيلزم أن تتحد المتكثرات المختلفة فيه ولزم تبدل الأجناس من غير تبدل
وتغير في الوجود أصلاً وذلك كتبدل الصورة بعضها ببعض في الهيولي عند
الفلاسفة من غير تبدل في الهيولي وذلك التمثيل أيضاً غير سديد فإن الهيولي
عندهم لا تعري عن الصورة إلا أن من الصور ما هو لازم للهيولي كالأبعاد
الثلاثة ومنها ما يتبدل كالأشكال والمقادير المختلفة والأوضاع والكيفيات
وبالجملة وجود مجرد مطلق عام غير مختلف كيف يتصور وجوده وما محله فإن كان
الجوهر محلاً له فقد بطل عمومه العرض فإن عنيتم العرض فقد بطل عمومه
الجوهر وإن لم يكن ذا محل وهو من أمحل المحال.
وعن هذه المطالبة
الحاقة يلوح الحق ولا نبوح به لأنا بعد في مدارج أقوال الفريقين فيقول
النافي كيف يتصور وجود على الحقيقة التي لا تتبدل ولا تتغير وإنما تتغير
أنواعه بعضها إلى بعض فيصير الجوهر عرضاً والعرض جوهراً والوجود لا يختلف
وذلك تجويز قلب الأجناس فالأول سريان الوجود الواحد في أجناس وأنواع
مختلفة والثاني اتحاد أنواع وأجناس مختلفة في وجود واحد.
وقال المثبتون
إلزام الحال علينا نقضاً غير متوجه فإن العموم والخصوص في الحال كالجنسية
والنوعية في الأجناس والأنواع فإن الجنسية في الأجناس ليس جنساً حتى
يستدعي كل جنس جنساً ويودي إلى التسلسل وكذلك النوعية في الأنواع ليست
نوعاً حتى يستدعي كل نوع نوعاً فكذلك الحالية للأحوال لا تستدعي حالاً
فيؤدي إلى التسلسل وليس يلزم على من يقول الوجود عام أن يقول للعام عام
وكذلك لو قال العرضية جنس فلا يلزمه أن يقول للجنس جنس وكذلك لو فرق فارق
بين حقيقة الجنس والنوع وفصل أحدهما عن الثاني بأخص وصف لم يلزمه أن يثبت
اعتباراً عقلياً في الجنس هو كالجنس ووجهاً عقلياً هو كالنوع فلا يلزم
الحال علينا بوجه لا من حيث العموم والخصوص ولا من حيث الاعتبار والوجه
وأنتم معاشر النفاة لا يمكنكم أن تتكلموا بكلمة واحدة إلا وإن تدرجوا فيها
عموماً وخصوصاً ألستم تنفون الحال ولم تعينوا حالاً بعينها هي صفة مخصوصة
مشار إليها بل أطلقتم القول وعممتم النفي وأقمتم الدليل على جنس شمل
أنواعاً أ، على نوع عم أشخاصاً حتى استمر دليلكم ومن نفى الحال لا يمكنه
إثبات التماثل في المتماثلات وإجراء حكم واحد فيها جميعاً فلو كانت
الأشياء تتمايز بذواتها المعينة بطل التماثل وبطل الاختلاف وذلك خروج عن
قضايا العقول.
وأما قولكم الوجود لو كان واحداً متشابهاً في جميع الموجودات لزم حصول شيء
في شيئين أو شيئين في شيء.
فنقول
يلزمكم في الاعتبارات والوجوه العقلية ما لزمنا في الوجود والحال فإن
الوجه كالحال والحال كالوجه ولا ينكر منكر أن الوجود يعم الجوهر والعرض لا
لفظاً مجرداً بل معنى معقولاً ومن قال كل موجود إنما يمايز موجوداً آخر
بوجوده لم يمكنه أن يجري حكم موجود في موجود آخر حتى أن من أثبت الحدوث
لجوهر معين لم يتيسر له إثبات الحدوث لجوهر آخر بذلك الدليل بعينه بل لزمه
أن يفهم على كل جوهر دليلاً خاصاً وعلى كل عرض دليلاً خاصاً ولا يمكنه أن
يقسم تقسيماً في المعقولات أصلاً لأن التقسيم إنما يتحقق بعد الاشتراك في
شيء والاشتراك إنما يتصور بعد الاختصاص بشيء ومن قال هذا جسم مؤلف فقد حكم
على جسم معين بالتأليف لم يلزمه جريان هذا الحكم في كل جسم ما لم يقل كل
جسم مؤلف ولو اقتصر على هذا أيضاً لم يفض إلى العلم بحدوث كل جسم ما لم
يقل وكل مؤلف محدث حتى يحصل العلم بأن كل جسم محدث فأخذ الجسمية عامة
والتأليف عاماً واستدعا التأليف للحدوث عاماً حتى لزمه الحكم بحدوث كل جسم
مؤلف عاماً فمن قال الأشياء تتمايز بذواتها المعينة كيف يمكنه أن يجري
حكماً في محكوم خاص فألزمتمونا قلب الأجناس وألزمناكم رفع الأجناس
ودعوتمونا إلى المحسوس ودعوناكم إلى المعقول وأفحتمونا بإثبات واحد في
اثنين واثنين في واحد وأفحمناكم بنفي الواحد في الاثنين والدليل متعارض
والدست قائم فمن الحاكم.
قال الحاكم المشرف على نهاية إقدام الفريقين
أنتم معاشر النفاة أخطأتم من وجهين من حيث رددتم العموم والخصوص إلى
الألفاظ المجردة وحكمتم بأن الموجودات المختلفة تختلف بذواتها ووجودها
فكلامكم هذا ينقض بعضه بعضاً ويدفع آخره أوله وهذا إنكار لأخص أوصاف العقل
أليس هذا الرد حكماً عاماً على كل عام وخاص بأنه راجع إلى اللفظ المجرد
أليست الألفاظ لو رفعت من البين لم ترتفع القضايا العقلية حتى البهائم
التي لا نطق لها ولا عقل لم تعدم هذه الهداية فإنها تعلم بالفطرة ما
ينفعها من العشب فتأكل ثم إذا رأت عشباً آخر يماثل ذلك الأول ما اعتراها
ريب في أنه مأكول كالأول فلولا أنها تخيلت من الثاني عين حكم الأول وهو
كونه مأكولاً وإلا لما أكلت وتعرف جنسها فتألف به وتعرف ضدها فتهرب منه
ولقد صدق المثبتون عليكم أنكم حسمتم على أنفسكم باب الحد وشموله للمحدودات
وباب النظر وتضمنه للعلم.
وأنا أقول لا بل حسمتم على العقول باب
الإدراك وعلى الألسن باب الكلام فإن العقل يدرك الإنسانية كلية عامة لجميع
نوع الإنسان مميزة عن الشخص المعين المشار إليه وكذلك العرضية كلية عامة
لجميع أنواع الأعراض من غير أن يخطر بباله اللونية والسوادية وهذا السواد
بعينه وهذا مدرك بضرورة العقل وهو مفهوم العبارة متصور في العقل لا نفس
العبارة إذ العبارة تدل على معنى في الذهن محقق هو مدلول العبارة والمعبر
عنه لو تبدلت العبارة عربية وعجمية وهندية ورومية لم يتبدل المعنى المدلول
ثم ما من كلام تام إلا ويختص معنى عاماً فوق الأعيان المشار إليها بهذا
وتلك المعاني العامة من أخص أوصاف النفوس الإنسانية فمن أنكرها خرج عن
حدود الإنسانية ودخل في حريم البهيمة بل هم أضل سبيلاً.
وأما الخطأ الثاني وهو رد التمييز بين الأنواع إلى الذوات المعينة وذلك من
أشنع المقالات فإن الشيء إنما يتميز عن غيره بأخص وصفه.
قيل
له أخص وصف نوع الشيء غير وأخص وصف الذات المشار إليها غير فإن الجوهر
يتميز عن العرض بالتحيز مطلقاً إطلاقاً نوعياً لا معيناً تعييناً شخصياً
والجوهر المعين إنما يمتاز عن جوهر معين بتحيز مخصوص لا بالتحيز المطلق
وقط لا يمتاز جوهر معين عن عرض معين بتحيز مخصوص إذ الجنس لا يميز الوصف
عن الموصوف والعرض عن الجوهر والعقل إنما يميز بمطلق التحيز فعرف أن
الذوات إنما تتمايز بعضها عن بعض تمايزاً جنسياً نوعياً لا بأعم صفاتها
كالوجود بل بأخص أوصافها بشرط أن تكون كلية عامة ولو أن الجوهر مايز العرض
بوجوده كما مايزه بتحيزه لحكم على العرض بأنه متحيز وعلى الجوهر بأنه
محتاج إلى التحيز لأن الوجود والتحيز واحد فما به يفترقان هو بعينه ما فيه
يشتركان وما به يتماثلان وهو بعينه ما فيه يختلفان ويرتفع التماثل
والاختلاف والتضاد رأساً ويلزم أن لا يجري حكم مثل في مثل حتى لو قام
الدليل على حدوث جوهر بعينه كان هو محدثاً ويحتاج إلى دليل آخر في مثل ذلك
الجوهر ويلزم أن لا يسلب حكم ضد عن ضد وخلاف عن خلاف حتى لو حكم على
الجوهر بأنه قابل للعرض لم يسلب هذا الحكم عن العرض إذ لا تماثل ولا
اختلاف ولا تضاد وارتفع العقل والمعقول وتعدد الحس والمحسوس.
وأما وجه
خطأ المثبتين للحال فهو أنهم أثبتوا لموجود معين مشار إليه صفات مختصة به
وصفات يشاركه فيها غيره من الموجودات وهو من أمحل المحال فإن المختص
بالشيء المعين والذي يشاركه فيه غيره واحد بالنسبة إلى ذلك المعين فوجود
عرض معين وعرضيته ولونيته وسواديته عبارات عن ذلك المعين المشار إليه فإن
الوجود إذا تخصص بالعرضية فهو بعينه عرض والعرضية إذا تخصصت باللونية فهي
بعينها لون وكذلك اللونية بالسوادية والسوادية بهذا السواد المشار إليه
فليس من المعقول أن توجد صفة لشيء واحد معين وهي بعينها توجد لشيء آخر
فتكون صفة معينة في شيئين كسواد واحد في محلين وجوهر واحد في مكانين ثم لا
يكون ذلك في الحقيقة عموماً وخصوصاً فإن مثل هذا ليس يقبل التخصيص إذ يكون
خاصاً في كل محل فلا يكون البتة عاماً وإذا لم يكن عاماً لم يكن خاصاً
أيضاً فيتناقض المعنى.
والخطأ الثاني أنهم قالوا الحال لا يوصف بالوجود
ولا بالعدم والوجود عندهم حال فكيف يصح أن يقال الوجود لا يوصف بالوجود
وهل هو إلا تناقض في اللفظ والمعنى وما لا يوصف بالوجود والعدم كيف يجوز
أن يعم أصنافاً وأعياناً لأن العموم والشمول يستدعي أولاً وجوداً محققاً
وثبوتاً كاملاً حتى يشمل ويعم أو يعين ويخص وأيضاً فهم أثبتوا العلة
والمعلول ثم قالوا العلة توجب المعلول وما ليس بموجود كيف يصير موجباً
وموجباً فالعلمية عندهم حال والعالمية عندهم أيضاً حال فالموجِب حال
والموجَب حال والحال لا يوجب الحال لأن ما لا يتصف بالوجود الحقيقي لا
يتصف بكونه موجباً.
الخطأ الثالث أنا نقول معاشر المثبتين كل ما
أثبتموه في الوجود هو حال عندكم فأرونا موجوداً في الشاهد والغائب هو ليس
بحال لا يوصف بالوجود والعدم فإن الوجود الذي هو الأعم الشامل للقديم
والحادث عندكم حال والجوهرية والتحيز وقبوله العرض كلها أحوال فليس على
مقتضى مذهبكم شيء ما في الوجود هو ليس بحال وإن أثبتم شيئاً وقلتم هو ليس
بحال فذلك الشيء يشتمل على عموم وخصوص والأخص والأعم عندكم حال فإذاً لا
شيء إلا لا شيء ولا وجود إلا لا وجود وهذا من أمحل ما يتصور.
فالحق في
المسئلة إذاً أن الإنسان يجد من نفسه تصور أشياء كلية عامة مطلقة دون
ملاحظة جانب الألفاظ ولا ملاحظة جانب الأعيان ويجد من نفسه اعتبارات عقلية
لشيء واحد وهي إما أن ترجع إلى الألفاظ المحددة وقد أبطلناه وإما أن ترجع
إلى الأعيان الموجودة المشار إليها وقد زيفناه فلم يبق إلا أن يقال هي
معان موجودة محققة في ذهن الإنسان والعقل الإنساني هو المدرك لها ومن حيث
هي كلية عامة لا وجود لها في الأعيان فلا موجود مطلقاً في الأعيان ولا عرض
مطلقاً ولا لون مطلقاً بل هي الأعيان بحيث يتصور العقل منها معنى كلياً
عاماً فتصاغ له عبارة تطابقه وتنص عليه ويعتبر العقل منها معنى ووجهاً
فتصاغ له عبارة حتى لو طاحت العبارات أو تبدلت لم تبطل المعنى المقدر في
الذهن المتصور في العقل فنفاة الأحوال أخطئوا من حيث ردها إلى العبارات
المجردة وأصابوا حيث قالوا ما ثبت وجوده معيناً لا عموم فيه ولا اعتبار
ومثبتو الأحوال أخطئوا من حيث ردوها إلى صفات في الأعيان وأصابوا من حيث
قالوا هي معان معقولة وراء العبارات وكان من حقهم أن يقولوا هي موجودة
متصورة في الأذهان بدل قولهم لا موجودة ولا معدومة وهذه المعاني مما لا
ينكرها عاقل من نفسه غير أن بعضهم يعبر عنها بالتصور في الأذهان وبعضهم
يعبر عنها بالتقدير في العقل وبعضهم يعبر عنها بالحقائق والمعاني التي هي
مدلولات العبارات والألفاظ وبعضهم يعبر عنها بصفات الأجناس والأنواع
والمعاني إذا لاحت للعقول واتضحت فليعبر المعبر عنها بما يتيسر له
فالحقائق والمعاني إذاً ذات اعتبارات ثلاث اعتبارها في ذواتها وأنفسها
واعتبارها بالنسبة إلى الأعيان واعتبارها بالنسبة إلى الأذهان وهي من حيث
هي موجودة في الأعيان يعرض لها أن تتعين وتتخصص وهي من حيث هي متصورة في
الأذهان يعرض لها أن تعم وتشمل فهي باعتبار ذواتها في أنفسها حقائق محضة
لا عموم فيها ولا خصوص ومن عرف الاعتبارات الثلاث زال إشكاله في مسئلة
الحال ويبين له الحق في مسئلة المعدوم هل هو شيء أم لا والله الموفق.
القاعدة السابعة
في المعدوم هل هو شيء أم لا
وفي الهيولي وفي الرد على من أثبت الهيولي بغير صورة الوجود والشيء أعرف من أن يحد بحد أو يرسم برسم لأنه ما من لفظ يدرجه في تحديد الشيء إلا وهو أخفى من الشيء والشيء أظهر منه وكذلك الوجود ولو أدرجت في التحديد ما أو الذي أو هو فذلك عبارة عن الوجود والشيئية فتعريفه بشيء آخر محال ولأن الشيء المعرف به أخص من الشيئية والوجود وهما أعم من ذلك الشيء فكيف يعرف شيئاً بما هو أخص منه وأخفى منه ومن حد الشيء أنه الموجود فقد أخطأ فإن الوجود والشيئية سيان في الخفا والجلا ومن حده ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فقد أخطأ فإنه أدرج لفظ ما في الحدود ومعناه أنه الشيء الذي يعلم فقد عرفه بنفسه لعمري قد يختلف الاصطلاح والمواضعة فالأشعرية لا يفرقون بين الوجود والثبوت والشيئية والذات والعين والشحام من المعتزلة أحدث القول بأن المعدوم شيء وذات وعين وأثبت له خصائص المتعلقات في الوجود مثل قيام العرض بالجوهر وكونه عرضاً ولوناً وكونه سواداً وبياضاً وتابعه على ذلك أكثر المعتزلة غير أنهم لم يثبتوا قيام العرض بالجوهر ولا التحيز للجوهر ولا قبوله للعرض وخالفه جماعة فمنهم من لم يطلق إلا اسم الشيئية ومنهم من امتنع من هذا الإطلاق أيضاً مثل أبي الهذيل وأبي الحسين البصري ومنهم من قال الشيء هو القديم وأما الحادث فيسمى شيئاً بالمجاز والتوسع وصار جهم بن صفوان إلى أن الشيء هو المحدث والباري سبحانه مشى الأشياء.قال نفاة
الشيئية عن العدم قد تقرر في أوائل العقول أن النفي والإثبات يتقابلان
والمنفي والمثبت يتقابلان تقابل التناقض حتى ا نفيت شيئاً معيناً في حال
مخصوص بجهة مخصوصة لم يمكنك إثباته على تلك الحال وتلك الجهة المخصوصة ومن
أنكر هذه القضية فقد أنكر هذه الحقائق كلها وإذا كان المنفي ثابتاً على
أصل من قال أن المعدوم شيء فقد رفع هذه القضية أصلاً وكان كمن قال لا
معقول ولا معلوم إلا الثبوت فحسب وذلك خروج عن القضايا الأولية وتحديد ذلك
أن كل معدوم منفي وكل منفي ليس بثابت فكل معدوم ليس بثابت.
قال من أثبت
المعدوم شيئاً كما تقرر في العقل تقابل النفي والإثبات فقد تقرر أيضاً
تقابل الوجود والعدم فنحن وفرنا على كل تقسيم عقلي حظه وقلنا أن الوجود
والثبوت لا يترادفان على معنى واحد والمعدوم والمنفي كذلك.
قالت النفاة
الآن صرحتم بالحق حيث ميزتم بين قسم وقسم فالثبوت عندكم أعم من الوجود فإن
الثبوت يشمل الموجود والمعدوم فهلا قلتم في المقابل كذلك وإن المنفي أعم
من المعدوم حتى يكون صفة عمومة حالاً أو وجهاً للمنفي ثابتاً كما كان صفة
خصوص المعدوم حالاً للمعدوم أو وجهاً ثابتاً فيتحقق أمر ثابت ويرتفع
المقابل العقلي وإن لم يثبتوا فرقاً بين المنفي والمعدوم ثم قالوا كل
معدوم شيء ثابت لزمهم أن يقولوا كل منفي شيء ثابت فرجع الإلزام عليهم
رجوعاً ظاهراً وهو رفع التقابل بين النفي والإثبات.
قال المثبتون إذا
حققتم الكلام في النفي والإثبات والموجود والمعدوم وميزتم بين الخصوص
والعموم فيه عاد الإلزام عليكم متوجهاً من وجهين أحدهما أنكم أثبتم في
المعدوم خصوصاً وعموماً أيضاً حتى قلتم منه ما هو واجب كالمستحيل ومنه ما
هو جائز كالممكن ومنه ما يستحيل لذاته كالجمع بين المتضادين ومنه ما
يستحيل لغيره كخلاف المعلوم فهذه التقسيمات قد وردت على المعدوم فأخذتم
المعدومية عامة وخصصتم بهذه الخصائص فلولا أن المعدوم شيء ثابت وإلا لما
تحقق فيه العموم والخصوص ولما تحقق التميز بين قسم وقسم.
والوجه الثاني
أنكم اعترفتم بأن المنفي والمعدوم معلوم وقد أخبرتم عنه وتصرفتم بأفكاركم
فيه فما متعلق العلم وما معنى التعلق إذا لم يكن شيئاً ثابتاً أصلاً.
قالت
النفاة نحن لا نثبت في العدم خصوصاً وعموماً بل الخصوص والعموم فيه راجع
إلى اللفظ المجرد وإلى التقدير في العقل بل العلم لا يتعلق بالمعدوم من
حيث هو معدوم إلا على تقدير الوجود فالعدم المطلق يعلم ويعقل على تقدير
الوجود المطلق في مقابلة العدم المخصوص أعني عدم شيء بعينه فأما أن يشار
إلى موجود محقق فيقال عدم هذا الشيء وإما أن يقدر في العقل فيقال عدم ذلك
المقدر كالقيامة تقدر في العقل ثم تنفى في الحال أو تثبت في المآل فالعدم
إذاً لا يخص ولا يعم ولا يعلم من غير وجود أو تقدير وجود فكان العلم يتعلق
بالموجود ثم من ضرورته أن يصير عدم ذلك الشيء معلوماً فيخبر عنه بأنه منفي
ويعبر عنه أنه ليس بشيء في الحال وإن كان شيئاً في ثاني الحال على أنا
نلزمكم الوجود نفسه والصفات التابعة للوجود عندكم مثل التحيز للجوهر
وقبوله للعرض وقيامه بالذات ومثل احتياج العرض إلى الجوهر وقيامه به فنقول
الوجود منفي من الجواهر أم ثابت فإن كان ثابتاً فهو تصريح بقدر العالم
وتقرير أن لا إبداع ولا اختراع ولا أثر لقادرية الباري سبحانه وتعالى
أصلاً وإن كان منفياً فكل منفي عندكم معدوم وكل معدوم ثابت فعاد الإلزام
عليكم جذعا.
ونقول قد قام الدليل على أن الباري سبحانه أوجد العالم
بجواهره وإعراضه فيقال أوجد عينها وذاتها أم غير ذاتها فإن قلتم أوجد
ذاتها وعينها فالعين والذات ثابتة في العدم عندكم وهما صفتان ذاتيتان لا
تتعلق بهما القدرة والقادرية ولا هي من آثارهما وإن قلتم أوجد غيرها
فالكلام في ذلك الغير كالكلام فيما نحن فيه.
قال المثبتون أما قولكم
في العلم يتعلق بالوجود أو بتقدير الوجود فإنه ينتقض بعلم الباري سبحانه
بعدم العالم في الأزل فإنه لا وجود للعالم في الأزل ولا تقدير الوجود من
وجهين أحدهما أن تقدير العالم في الأزل محال والثاني أن التقدير من الباري
سبحانه محال فإنه ترديد الفكر بوجود شيء وعدمه فإن قدر في ذاته فهو محال
وإن فعل فعلاً سماه تقديراً فهو محال في الأزل ولا بد للعلم من متعلق وهو
معلوم محقق فوجب أن يكون شيئاً ثابتاً.
وقولكم العلم يتعلق بوجود الشيء
في وقت وجوده ثم يلزم من ضرورته العلم بعدمه قبل وجوده يلزمكم حصر العلم
في معلومات هي موجودات والموجودات متناهية فيجب تناهي المعلومات وأنتم لا
تقولون به ثم تلك اللوازم إن كانت معلومة فهي كالموجودات على السواء في
تعلق العلم بها وإن لم تكن معلومة فقد تناهى العلم والمعلومات.
وأما
قولكم أن الوجود منفي أم ثابت فعلى أصلنا الوجود منفي وليس بثابت وليس كل
منفي ومعدوم عندنا ثابتاً فإن المحالات منفيات ومعدومات وليست أشياء ثابتة
بل سر مذهبنا أن الصفات الذاتية للجواهر والأعراض هي لها لذواتها لا تتعلق
بفعل الفاعل وقدرة القادر إذ أمكننا أن نتصور الجوهر جوهراً أو عيناً
وذاتاً والعرض عرضاً وذاتاً وعيناً ولا يخطر ببالنا أنه أمر موجود مخلوق
بقدرة القادر والمخلوق والمحدث إنما يحتاج إلى الفاعل من حيث وجوده إذا
كان في نفسه ممكن الوجود والعدم وإذا ترجح جانب الوجود احتاج إلى مرجح فلا
أثر للفاعل بقادريته أو قدرته إلا في الوجود فحسب فقلنا ما هو له لذاته قد
سبق الوجود وهو جوهريته وعرضيته فهو شيء وما هو له بقدرة القادر هو وجوده
وحصوله وما هو تابع لوجوده فهو تحيزه وقبوله للعرض وهذه قضايا عقلية
ضرورية لا ينكرها عاقل.
وعلى هذه القاعدة يخرج الجواب عن أثر الإيجاد
فإن تأثير القدرة في الوجود فقط والقادر لا يعطيه إلا الوجود والممكن في
ذاته لا يحتاج إلى القادر إلا من جهة الوجود ألسنا نقول إن إمكان الممكن
من حيث إمكانه أمر لذاته وهو من هذا الوجه غير محتاج إلى الفاعل وليس
للفاعل جعله ممكناً لكن من حيث ترجيح أحد طرفي الإمكان كان محتاجاً إلى
الفاعل فعلم يقيناً أن الأمور الذاتية لا تنسب إلى الفاعل بل ما يعرض لها
من الوجود والحصول ينسب إلى الفاعل ونقول أن الفاعل إذا أراد إيجاد جوهر
فلا بد أن يتميز الجوهر بحقيقته عن العرض حتى يتحقق القصد إليه بالإيجاد
وإلا فالجوهر والعرض في العدم إذا كان لا يتميز أحدهما عن الثاني بأمر ما
وحقيقة ما وذلك الأمر والحقيقة لم يكن شيئاً ثابتاً لم يتجرد القصد إلى
الجوهر دون العرض وإلى الحركة دون السكون والبياض دون السواد إلى غير ذلك
والتخصيص بالوجود إنما يتصور إذا كان المخصص معيناً مميزاً عند المخصص حتى
لا يقع جوهر بدل عرض ولا حركة بدل سكون ولا بياض بدل سواد فعلم بذلك أن
حقائق الأجناس والأنواع لا تتعلق بفعل الفاعل وأنها في ذواتها إن لم تكن
أشياء منفصلة لم يتصور الإيجاد والاختراع ولكان حصول الكائنات على
اختلافها اتفاقاً وبختاً.
قالت النفاة العلم الأزلي يتعلق
بالمعلومات كلها كما هي فيتعلق بوجود العالم حتى يتحقق له الوجود ويتعلق
باستحالة وجوده أزلاً وجواز وجوده قبل وجوده لكن المتعلق الحقيقي هو
الوجود وسائر المعلومات من ضرورة ذلك التعلق ولا يستدعي ذلك التعلق في حق
الباري سبحانه تقديراً وهمياً وترديداً خيالياً هذا كمن عرف وحدانية
الباري سبحانه وتعالى في الإلهية عرف إنما سواه ليس بإلاه ولا يستدعي تعدد
علوم بكل مخلوق أنه ليس بإلاه ومن عرف أن زيداً في الدار عرف أنه ليس
بموضع آخر سواها ولا يستدعي ذلك أن يتعدد علمه بأنه ليس في دار عمر وبكر
وخالد بل يقع ذلك معلوماً لزوماً ضرورةً ومثل هذه المعلومات لا تتناهى
ويستحيل أن يقال هذه المعلومات أشياء ثابتة حتى يكون عدم زيد في مكان كذا
أو عدم كل جوهر في حيز كذا أو عدم كل عرض في محل كذا إلى ما لا يتناهى
أشياء ثابتة في العدم فإن ذلك خروج عن قضايا العقل وتيه في مفازة الجهل
وأما إلزام الوجود من حيث هو وجود والتحيز وقبول العرض وجميع الصفات
التابعة للحدوث فمتوجه والاعتذار بأنه منفي وليس بثابت ولا شيء نقض صريح
لمذهبهم فإن كل معلوم أمكن الإخبار عنه وتعلق العلم به فهو شيء ثابت عندهم
ويا ليت شعري إذا لم يمكن الإخبار عن الوجود ولم يمكن تعلق العلم به فعن
أي شيء يخبر وعن أي شيء يعلم وليس ذلك كالمحال الذي تمثلوا به على أن
المحالات مما يعلم ويخبر عنها فهلا كانت أشياء حتى يلزم أن يكون عدم
الإلهية أشياء ما والعالم بما فيه من الجواهر والأعراض أشياء ثابتة في
الأزل وكما لا تتناهى المعلومات لا تتناهى الأشياء بأجناسها وأنواعها
وأصنافها والعياذ بالله من مذهب هذا مآله وأما كلامكم في الصفات الذاتية
أنها لا تحصل بفعل الفاعل وإنما الوجود من حيث هو وجود متعلق القدرة فشيء
ما سمعوه ولم يفهموه وما أحسنوا إيراده لأنهم لم يتحققوا إصداره.
وأجابت
النفاة بأن قالوا وجود الشيء وعينه وذاته وجوهريته وعرضيته عندنا عبارات
عن معبر واحد وما أوجده الموجد فهو ذات الشيء والقدرة تعلقت بذاته كما
تعلقت بوجوده وأثرت في جوهريته كما أثرت في حصوله وحدوثه والتميز بين
الوجود وبين الشيئية مما لا يؤل إلى معنى ومعنى بل إلى لفظ ولفظ وهم على
اعتقاد أن الأجناس والأنواع والعموم والخصوص فيها راجع إلى الألفاظ
المجردة أو الوجوه العقلية والتقديرات الوهمية وألزموا عليهم الصفات
التابعة للحدوث كالتحيز وقبول العرض وقيام العرض بالمحل فإنها ليست من
آثار القدرة ثم لم يثبتوها قبل الحدوث فهلا قالوا الصفات الذاتية كلها
تتبع الحدوث أيضاً وربما عكسوا عليهم الأمر في التابع والمتبوع وألزموهم
القول بأن التحيز يقع بالقدرة والوجود يتبعه.
وأجابوا عن سؤال التخصيص
والتمييز بالمعارضة وهو أن الجواهر والأعراض لو ثبتت في العدم بغير نهاية
لما تحقق القصد إلى بعضها بالتخصيص وليس يندفع الإشكال بهذا الجواب بل
يزيده قوة ولزوماً.
والحق أن هذه المسئلة مبنية على مسئلة الحال وقد
دارت رؤوس المعتزلة في هاتين المسئلتين على طرفي نقيض فتارة يعبرون عن
الحقائق الذاتية في الأجناس والأنواع بالأحوال وهي صفات وأسماء ثابتة
للموجودات لا توصف بالوجود ولا بالعدم وتارة يعبرون عنها بالأشياء وهي
أسماء وأحوال ثابتة للمعدومات لا تخص بالأخص ولا تعم بالأعم وذلك أنهم
سمعوا كلاماً من الفلاسفة وقروا شيئاً من كتبهم وقبل الوصول إلى كنه
حقيقته مزجوه بعلم الكلام غير نضيج وذلك أنهم أخذوا من أصحاب الهيولي
مذهبهم فيها فكسوه مسئلة المعدوم وأصحاب الهيولي هم على خطأ بين من إثبات
الهيولي مجرد عن الصورة كما سنرد عليهم وأخذوا من أصحاب المنطق والإلهيين
كلامهم في تحقيق الأجناس والأنواع والفرق بين المتصورات في الأذهان
والموجودات في الأعيان وهم على صواب ظاهر دون الخناثى من المعتزلة لا رجال
ولا نساء لأنهم أثبتوا أحوالاً لا موجودة ولا معدومة والصورة كالمتصور
وينهدم بنيانهم بأوهى نفخة كما يتضح الحق لأوليائه بأدنى لمحة.
فنقول
إذا أشار مشير إلى جوهر بعينه فنسألكم هل كان هذا الجوهر قبل وجوده شيئاً
ثابتاً جوهراً جسمياً من حيث هو هذا أم كان جوهراً مطلقاً شيئاً عاماً غير
متخصص بهذا.
فإن قلتم كان بعينه جوهراً فيجب أن تحقق الإشارة إليه
بهذا ويكون ذلك المشار إليه هو هذا لأن هذا لا يشاركه فيه غير هذا وإن كان
قبل وجوده جوهراً مطلقاً لا هذا فلم يكن ذلك هذا فلم يكن هذا شيئاً
والمطلق من حيث هو مطلق لا هذا ولم يكن هذا ذاك ولا ذاك هذا فما هو ثابت
في العدم لم يتحقق له وجود وما تحقق له وجود لم يكن ثابتاً.
وما ذكروه
أن الصفات الذاتية لا تنسب إلى الفاعل بل الذي ينسب إلى الفاعل هو الوجود
قيل ما ثبت للشيء الغير المعين من الصفات التي هو بها قد تعين غير وما ثبت
للشيء المعين من الصفات التي هو بها وقد تفنن وتنوع غير والأول لا يسمى
صفات ذاتية إلا بمعنى أنها عبارات عن ذاته المعينة فيكون وجوده وجوهريته
وعينه وذاته عبارات عن معبر واحد وكما يحتاج في وجوده إلى الموجد يحتاج في
ذاته وعينه وجوهريته وجواز الوجود هو بعينه جواز الثبوت وهو بعينه في أن
يكون عيناً وبجوهريته في أن يكون جوهراً لا يستغني عن الموجد وإلا فيلزم
أن تستغني الأشياء كلها عن الموجد من جميع وجوهها وصفاتها إلا الوجود فحسب
علي أنه حال لا يوصف بالوجود وأيضاً فإن الوجود ليس يفتقر إلى الموجد وإلا
فيلزم وجود القديم بل وجود مخصص هو بصفة الإمكان يفتقر إلى الموجد ثم
الموجد الممكن من حيث هو عام لا يتحقق له وجود بل وجود ممكن هو بصفة كذا
أو كذا ويتحقق له وجود فيثبت أن المعين المشار إليه هو المفتقر إلى الموجد
لكن لا يتحقق له وجود إلا ويريده الموجد وليس يريده الموجد إلا ويعلمه قبل
إيجاده فيتخصص وجوده وجوداً عرضاً جوهراً في علم الموجد فالمعلوم يتخصص
مراداً والمراد يتخصص وجوداً هو بعينه جوهر إلا أنه في ذاته يكون شيئاً
فيخصصه الوجود بعد الشيء حتى تتخصص الشيئية الخارجة جوهراً وتتخصص
الجوهرية العامة الخارجة بهذا الجوهر وأيضاً فإن الوجود أعم صفات
الموجودات وإيجاد الأعم لا يوجب وجود الأخص فلو كان البياض مثلاً منتسباً
إلى الموجد من حيث وجوده فقط لكان يكون موجوداً لا بياضاً بل لو عكس الأمر
وقلب الحال فقبل أوجده سواداً أو بياضاً وانتسبت البياضية إلى الموجد فقط
ولكن من ضرورة وجود الأخص وجود الأعم كان أمثل من حيث العقل ولذلك نقول إن
البياض يضاد السواد ببياضيته فإذا انتفى السوادية انتفى الوجود إذ ليس من
قضية العقل انتفاء السوادية وبقاء الوجود وعند القوم أن المعدوم عادم
لوجوده كما أن الموجود واجد لوجوده فيلزم على ذلك أن لا يوجد بياض ولا
يعدم سواد ولا يتحقق جوهر ولا يتخصص عرض.
والعجب كل العجب من مثبتي
الأحوال أنهم جعلوا الأنواع مثل الجوهرية والجسمية والعرضية واللونية
أشياء ثابتة في العدم لأن العلم قد تعلق بها والمعلوم يجب أن يكون شيا حتى
يتوكأ عليه العلم ثم هي بأعيانها أعني الجوهرية والعرضية واللونية
والسوادية أحوال في الوجود ليست معلومة على حيالها ولا موجودة بانفرادها
فيا له من معلوم في العدم يتوكأ عليه العلم وغير معلوم في الوجود ولو أنهم
اهتدوا إلى مناهج العقول في تصورها الأشياء بأجناسها وأنواعها لعلموا أن
تصورات العقول ماهيات الأشياء بأجناسها وأنواعها لا تستدعي كونها موجودة
محققة أو كونها أشياء ثابتة خارجة عن العقول أو ما لها بحسب ذواتها
وأجناسها وأنواعها في الذهن من المقومات الذاتية التي تتحقق ذواتها بها لا
تتوقف على فعل الفاعل حتى يمكن أن تعرف هي والوجود لا يخطر بالبال فإن
أسباب الوجود غير وأسباب الماهية غير ولعلموا أن إدراكات الحواس ذوات
الأشياء بأعيانها وأعلامها تستدعي كونها موجودة محققة وأشياء ثابتة خارجة
عن الحواس وما لها بحسب ذواتها من كونها أعياناً وأعلاماً في الحس من
المخصصات العرضية التي تحقق ذواتها المعينة بها هي التي تتوقف على فعل
الفاعل حتى لا يمكن أن توجد هي عرية من تلك المخصصات فإن أسباب الماهية
غير وأسباب الوجود غير ولما سمعت المعتزلة من الفلاسفة فرقاً بين القسمين
ظنوا أن المتصورات في الأذهان هي أشياء ثابتة في الأعيان فقضوا بأن
المعدوم شيء وظنوا بأن وجود الأجناس والأنواع في الأذهان هي أحوال ثابتة
في الأعيان فقضوا بأن المعدوم شيء وأن الحال ثابت ساء سمعاً وساء إجابة
ولولا أني التزمت على نفسي في هذا الكتاب أن أبين مصادر المذاهب ومواردها
واشتراك منتها إقدام العقول في مسائل الأصول وإلا لما أهمني كشف الأسرار
وهتك الأستار.
وأما أصحاب الهيولي فافترقت فيها على طريقين فرقتين
أحدهما إثبات هيولي للعالم مجردة عن الصور وعدوها من المبادئ الأول وهي
ثالثها أو رابعها فقالوا المبادئ هي العقل والنفس والهيولي وقالوا المبادئ
هو الباري سبحانه والعقل والنفس والهيولي وهي كانت مجردة عن الصور كلها
فحدثت الصورة الأولى وهي الأبعاد الثلاثة فصارت جسماً مركباً ذا طول وعرض
وعمق ولم يكن لها قبل الصورة إلا استعداد لمجرد القبول فإذا حدثت الصورة
صارت بالفعل موجودة وهي الهيولي الثانية ثم إذا لحقها الكيفيات الأربعة
التي هي الحرارة والبرودة الفاعلتان والرطوبة واليبوسة المنفعلتان صارت
الأركان التي هي النار والماء والهواء والأرض وهي الهيولي الثالثة ثم
تتكون منها المركبات التي تلحقها الأعراض وهي الكون والفساد ويكون بعضها
هيولي بعض.
الطريق الثاني هو أنهم أثبتوا الهيولي غير مجردة عن الصورة
قالوا وهذا الترتيب الذي ذكرناه مقدر في العقل والوهم خاصة دون الوجود
وليس في الوجود جوهر مطلق قابل للأبعاد ثم يلحقه الأبعاد ولا جسم عار عن
الكيفيات ثم عرضت له الكيفيات وإنما هو عندما نظرنا في ما هو أقدم بالطبع
وأبسط في الوهم والعقل.
قال أصحاب الهيولي المجردة أما إثبات الهيولي
لكل جسم فأمر معقول محقق بالبرهان وذلك أن كل جسم قابل للاتصال والانفصال
والتصور والتشكل بالصورة والأشكال ومعلوم أن قابل الاتصال والانفصال أمر
وراء الاتصال والانفصال فإن القابل يبقى بطريان أحدهما والاتصال لا يبقى
بعد طريان الانفصال وبالعكس فظاهر أن ها هنا جوهر غير الصورة الجسمية يعرض
له الاتصال والانفصال معاً ثم قالوا ما من انفصال واتصال معين إلا ويمكن
زواله وما من شكل وصورة وحيز وجهة إلا وهو عارض لذلك الجوهر فيمكن أن
يتعرى عن جميع الصور كما أمكن أن يتعرى عن كل صورة بل يجب أن يكون مبدأ
الأجسام المركبة جوهر غير مركب فإن كل مركب لو كان عن مركب لتسلسل إلى غير
النهاية فتركب القميص من الغزل والغزل من القطن والقطن من الأركان
والأركان من العناصر وهي الهيولي القابلة للصور والكيفيات فإذا انحلت
التركيبات فهي البسائط وإذا انحلت البسائط فهي الهيولي المجردة عن كل صورة
القابلة لكل صورة.
قال أصحاب الهيولي مع الصورة أما إثبات الهيولي
جوهراً معقولاً فمسلم للعقل وأما جواز تعريها عن الصور أو وجوب ذلك فهو
المختلف فيه وما أوردتموه من المقدمات تحكمات فلم قلتم أنه إذا أمكن
تعريها عن اتصال وانفصال معين أمكن تعريها عن كل اتصال وانفصال لأن الذي
يتبدل ويتغير من الاتصال والانفصال عرض من باب الكم والاتصال الذي هو
الأبعاد الثلاثة جوهر هو صورة جسمية فما هو عرض يجوز عليه التبدل وما هو
جوهر لم يتبدل قط وليس العرض من قبيل الجوهر حتى يحكم عليه بحكم الثاني
وكذلك كون الجسم في حيز مخصوص من قبيل الأعراض من باب الأين وكونه متحيزاً
صورة جسمية هو من قبيل الجواهر فلم يجز أن يقال إذا جاز عليه تبدل المكان
المخصوص جاز عليه أن لا يكون له حيز ومكان هذا جواب الحكيم للحكيم.
أما جواب المتكلم فيقول لم إذا جاز خلو الجوهر عن عرض جاز خلوه عن كل عرض.
قال
لأن الجوهر هو القائم بذاته المستغني عن المحل فلو لم يجز خلوه عن الأعراض
لبطل قيامه بذاته ولكن في وجوده محتاجاً إلى العرض كما كان العرض في وجوده
محتاجاً إلى الجوهر وحينئذ يلتبس حد الجوهر بحد العرض ويختلط أحدهما
بالآخر وذلك خروج عن المعقول.
فيقول المتكلم الجوهر في قيامه بذاته
يستغني عن محل يحل فيه بحيث يوصف المحل به والعرض في احتياجه من حيث ذاته
يحتاج إلى محل يحل فيه بحيث يوصف المحل به لكن لا يجوز أن يخلو الجوهر عن
كل الأعراض لا لأنه يحتاج إليها في قيامه بذاته جوهراً لكن في وجوده لا
يتصور أن يكون خالياً عن كون في مكان مخصوص.
وقال أصحاب الصور لو قدرنا
الهيولي جوهراً قائماً بذاته عرياً عن الصور كلها حتى لا يكون له وضع وحيز
وبعد واتصال ومقدار يقبل الانقسام ثم قدرناه حصل فيه المقدار مثلاً فإما
أن يصادفه المقدار دفعة أو على تدريج فإن صادفه دفعة حتى حصل ذا مقدار
فيكون قد صادفه بحيث حتى انضاف إليه فيكون له حيث وحيز فيدب أن يكون ذا
حيز أولاً حتى يصادفه حيث هو فيكون ذا صورة وإن صادفه على تدريج أو انبساط
فكل ما من شأنه أن ينبسط فله جهات وكل ما له جهة فهو ذو وضع وعلى الوجهين
جميعاً لا يصادفه الاتصال والمقدار إلا أن يكون له حيث وحيز ووضع وقد فرض
غير متحيز وذا وضع فهو خلف.
قال أصحاب الهيولي كل حادث في زمان فيجب أن
يسبقه إمكان الوجود وذلك الإمكان إما أن يكون في نفس المقدر وإما أن يكون
في شيء وبطل أن يكون في نفس المقدر فإن المقدر لو قدر عدمه لم ينعدم
الإمكان فيتعين أنه في شيء ما خارج عن الذهن ولا يخلو إما أن يكون موجوداً
أو معدوماً ومحال أن يكون معدوماً فإن المعدوم قبل والمعدوم مع شيء واحد
وليس الإمكان قبل هو الإمكان مع وإن كان موجوداً فإما أن يكون قائماً في
موضوع وإما أن يكون قائماً لا في موضوع فكل ما هو قائم لا في موضوع فله
وجود خاص لا يجب أن يكون به مضافاً وإمكان الوجود بما هو إمكان أمر مضاف
لما هو إمكان له فهو إذاً أمر في موضوع عارض لموضوع ونحن نسميه قوة الوجود
والذي فيه قوة وجود الشيء والموضوع والمادة والهيولي قالوا والإمكان قد
يعري عن الوجود لأنه لو تحقق وجود كل ممكن لحصلت موجودات بغير نهاية
فالعالم قد سبقه إمكان الوجود وقد سبقه الهيولي التي فيها الإمكان
والإمكان لم يكن في الأزل فالهيولي لم تكن في الأزل فتصور وجود العالم حيث
تحقق الهيولي وتحقق الهيولي حيث تحقق الإمكان والإمكان والوجوب لا يجتمعان.
وهذا
دليل افلاطن ألا هي في حدوث العالم بصورته وهيولاه قال وكما تصور وجود
موجودات كلية في العقل تصور وجود موجودات كلية في الخارج عن العقل وهي
حقائق مختلفة تختلف بالخواص كالعقول السماوية.
وقال أصحاب الصور هذا
البرهان صحيح في الموجودات الزمانية لكن كما لا يتحقق إمكان إلا في مادة
لا تتصور مادة إلا متصورة بصورة فإنها إن كانت عرية عن الصور كلها كان لا
يتحقق نحوها قصد الفاعل حتى يفيض عليها الصور إذ لا حيث لها ولا وضع ولا
أين وكما أن الإمكان ليس شيئاً متقوماً إلا بالهيولي والهيولي ليس شيئاً
متقوماً إلا بالصورة فيقوم الهيولي بالصورة وتقوم الصورة بواهب الصورة
وليس تنفك إحداهما عن الثانية بحال أصلاً.
برهان آخر لو قدرنا
الهيولي موجودة متقومة فأما أن يقال هي واحدة أو كثيرة فإن كانت واحدة ثم
صارت اثنين أفبانضمام آخر إليه أم بتكثير ذلك الواحد في نفسه من غير
انضمام من خارج فإن قدر الأول فهما جوهران انضم أحدهما إلى الثاني ويكون
الهيولي اثنين وما تحقق فيه الاثنينية قبل القسمة إما بالانفصال إذا كانا
متصلين وإما بالعدد إذا كان مقدارين وكل ذلك صورة وإن تكثر الواحد في نفسه
من غير انضمام من خارج كان حين كان واحداً لم يقبل القسمة ثم صار قابلاً
للقسمة فتكون له صورة الوحدة تارة وصورة التكثر تارة فيكون ذا صورتين
ويلزم أن يكون بين الحالتين مادة مشتركة بها يقبل الوحدة تارة والكثرة
أخرى فيكون للمادة مادة ويتسلسل وكذلك لو فرضنا اثنين جوهرين ثم خلعنا
صورة الاثنينية فصار شيئاً واحداً فلا يخلو إما أن يتحدا وكل واحد منهما
موجود أو أحدهما موجود والآخر معدوم أو كلاهما معدومان وحصل ثالث بالإيجاد
فإن كان فهما إذاً اثنان لا واحد وإن اتحدا واحدهما معدوم والآخر موجود
فالمعدوم كيف يتحد بالموجود وإن عدما بالإيجاد حصل ثالث فهما غير متحدين
بل لا بد من معدومين ويلزم أيضاً في خلع صورة الاثنينية مادة مشتركة كما
لزم في لباس صورتها مادة مشتركة فيتحقق بهذه البراهين أن الهيولي قط لا
تعري عن الصورة بل قوامها بالفعل يكون بالصورة وقوام الصورة من حيث ذاتها
لا يكون بها بل بواهب الصورة فكانت الهيولي حافظة لها قبولاً وكانت الصورة
مقومة لها وجوداً فالصورة لا تحدث إلا في الهيولي والهيولي لا تعري عن
الصورة وكل واحد منهما جوهر لأن الجسم مركب منهما والجسم جوهر والبسيطان
جوهران والتمييز بينهما بالفعل غير متصور والفصل بينهما فصل بالعقل وفي
المسئلة بقايا من المباحثات بين الفريقين وذلك حظ الحكمة الفلسفية لا حظ
الحقائق الكلامية وقد عرفت من هذه المباحثة أن مذهب المعتزلة في المعدوم
شيء هو بعينه مذهب بعض الفلاسفة في أن الهيولي موجودة قبل وجود الصورة
والله الموفق.
القاعدة الثامنة
في إثبات العلم بأحكام الصفات العلى
قد شرع المتكلمون في إثبات العلم بأحكام الصفات قبل الشروع في إثبات العلم بالصفات لأن الأحكام إلى الإذهان أسبق والمخالفون من المعتزلة في إثبات الصفات يوافقون في أحكام الصفات.وسلكوا طريقين أحدهما النظر والاستدلال والثاني الضرورة والبديهة ثم منهم من يرى الابتدا بإثبات كونه قادراً أولى ومنهم من يثبت كونه عالماً أولاً ثم يثبت كونه قادراً مريداً ومنهم من يبتدي بالإرادة ثم يثبت كونه قادراً عالماً.
قال أصحاب النظر في إثبات كونه قادراً أولاً أن الدليل قد قام على أن الصنع الجائز ثبوته والجائز عدمه إذا وجد احتاج إلى صانع يرجح جانب الوجود فيجب أن يكون الصانع قادراً لأن من الأحياء من يتعذر عليه الفعل ومنهم من يتيسر فسبرنا جملة صفات الحي روماً للعثور على المعنى الذي لأجله ارتفع التعذر وتحقق التأتي والتيسر فلم نجد صفة إلا القدرة أو كونه قادراً فكان الذي صحح الفعل من الحي كونه قادراً هو علة لصحة الفعل والعلة لا تختلف حكمها شاهداً وغائباً وكذلك صادفنا أحكاماً وإتقاناً في الأفعال وسبرنا ما لأجله يصح الأحكام والإتقان من الفاعل فلم نجد إلا كونه عالماً وكذلك رأينا الاختصاص ببعض الجائزات دون البعض مع تساوي الكل في الجواز وسبرنا ما لأجله يصح الاختصاص فلم نجد إلا كونه مريداً ثم لم يتصور وجود هذه الصفات إلا وأن يكون الموصوف بها حياً لأن الجماد لا يتصور منه أن يكون قادراً أو عالماً فقلنا القادر حي وأيضاً فإنا لو لم نصفه بهذه الصفات لزمنا وصفه بأضدادها من العجز والجهل والموت وتلك نقائص مانعة من صحة الفعل المحكم ويتعالى الصانع عن كل نقص.
ولخصومهم من المعطلة هذه الطريقة أسولة منها ما هو على الأشعرية سؤالان ومنها على المعتزلة آخران ومنها سؤال على جميع المتكلمين أما السؤال الأول فقالوا أنتم إذا نفيتم الحال وقلتم الأشياء في حقائقها تتمايز بذواتها ووحدها فكيف يستمر لكم الجمع بين الشاهد والغائب الثاني إنكم ما أثبتم في الشاهد فاعلاً موجداً على الحقيقة وإن أثبتم فاعلاً مكتسباً فكيف يستمر لكم الجمع بين ما لم يتصور منه الإيجاد وبين ما لم يتصور منه الاكتساب
أجاب الأصحاب عن السؤال الأول بأنا وإن نفينا
الحال صفة ثابتة لعين مشار إليها لم تنف الوجوه والاعتبارات العقلية جمعاً
بين الشاهد والغائب بالعلة والمعلول والدليل والمدلول وغير ذلك فإن العقل
إذا وقف على المعنى الذي لأجله صح الفعل من الفاعل في الشاهد حكم على كل
فاعل كذلك.
وأما الثاني فإنا وإن لم نثبت إيجاداً وإبداعا في الشاهد
إلا أنا نحس في أنفسنا تيسراً وتأتياً وتمكنا من الفعل وبذلك الوجه امتازت
حركة المرتعش عن حركة المختار وهذا أمر ضروري ثم وجه تأثير القدرة في
المقدور أهو إيجاد أم اكتساب نظر ثان ونحن بهذا الوجه جمعنا لا بذلك الوجه
الذي فرقتم.
أما السؤال على المعتزلة قالوا من أثبت الحال منكم لم يثبت
للفعل أثراً من الفاعل إلا حالاً لا توصف بالوجود والعدم والقادرية أيضاً
عندكم حال فكيف أوجدت حالةٌ حالةً.
والثاني أنكم أثبتم تأثيراً للقدرة
الحادثة في الإيجاد وما أثبتم للقدرة في الغائب إلا حالاً فما أنكرتم أن
المصحح للإيجاد هو كونه قدرة لا كونه قادراً فما حصل في الشاهد لم يوجد في
الغائب وما ثبت في الغائب لم يثبت في الشاهد ثم أثبتم تأثيراً في إيجاد
حركات دون الألوان والأجسام فإن جمعتم بين الشاهد والغائب بمجرد الحدوث
فقولوا فإن القدرة الحادثة تصلح لإيجاد كل موجود وإن تقاصرت القدرة في
الشاهد حتى لم يجمع بين محدث ومحدث في الشاهد فكيف يصح الجمع بين محدث في
الشاهد ومحدث في الغائب.
وأما السؤال على الفريقين قالوا هذا تمسك
باستقراء الحال وهو فاسد من وجوه كثيرة منها أنكم وجدتم في بعض الفاعلين
أن البناء يدل على الباني وقلتم سبرنا صفات الباني وعثرنا على كونه قادراً
فما أنكرتم أن بانياً يصدر عنه البناء ويكون حكمه على خلاف هذا الباني حتى
لا يستدعي كونه قادراً كما أنكم ما رأيتم بانياً إلا بآلة وأدات فلو حكمتم
على كل بان بآلة وأداة كان الحكم فاسداً كذلك في كونه قادراً أو ذا قدرة
أليست المعتزلة تخالفكم في القدرة والعلم والإرادة وأنتم تقولن البناء يدل
على كون الباني ذا قدرة وعلم وإرادة ثم لم تطردوا هذا الحكم غائباً فإذاً
يلزمكم دليل مستأنف في حق الغائب ولا يغنيكم دعوى الضرورة في هذا الجمع
فأنتم معاشر المعتزلة يلزمكم في استقرائكم الشاهد كون الصانع ذا قدرة وعلم
وإرادة وأنتم معاشر الأشاعرة يلزمكم في استقرائكم الشاهد كون الصانع ذا
بنية وآلة وأداة وبالجملة الأستقراء ليس يوجب علماً وإن ادعيتم الضرورة
فما بالكم شرعتم في الدليل.
قال القاضي أبو بكر رحمه الله إذا كنا نعود
في آخر الاستدلال بعد السبر والتقصير والترديد والتحويم إلى دعوى الضرورة
فما بالنا لم ندع البديهة والضرورة في الابتداء.
فنقول إذا أحاط المرء
علماً ببدائع الصنع وعجائب الخلق من سير المتحركات على نظام وترتيب وثبات
الساكنات على قوام وتسديد وحصول الكائنات بين المتحركات والساكنات فمن
جماد ونبات ومن حيوان ومن إنسان وكل بإحكام وإتقان عرف يقيناً أن الصانع
عالم حكيم قادر مريد ومن استراب عن ذلك كان عن العقل خارجاً وفي تيه الجهل
والجاً ولسنا نحتاج في ذلك إلى إثبات فعل في الشاهد ثم طرد ذلك في الغائب
بل الغائب شاهد والعقل رائد والبصر ناقد ومن حاول الاستدلال في مناهج
الضروريات عمي من حيث يبصر وجهل من حيث يستبصر.
وأجاب إمام الحرمين
عن سؤال الاستقراء بأن قال نحن لم نستقر الحال في الشاهد ولا نحكم على
الغائب بحكم الشاهد لكنا نقول قام الدليل على حدوث العالم واحتياجه من حيث
إمكانه إلى مرجح لأحد طرفي الإمكان والمرجح إما أن يرجح بذاته ولذاته أو
بذاته على صفة أو بصفة وراء الذات واستحال الترجيح والتخصيص بالوجود
بالذات من حيث هو ذات بأن الموجب بالذات لا يخصص مثلاً عن مثل فإن نسبة
الذات إلى هذا المثل كنسبته إلى المثل الثاني فيجب أن يكون بصفة وراء
الذات أو بذات على صفة وقد ورد التنزيل والشرع بتسمية تلك الصفة التي
يتأتى بها التخصيص إرادة ثم الإرادة تخصص ولا توقع فالصفة التي يتأتى بها
الإيقاع والإيجاد هي القدرة والفعل إذا اشتمل على إتقان وإحكام وجب
بالضرورة كون الصانع عالماً والإرادة أيضاً لا تتعلق بشيء إلا بعد أن يكون
المريد عالماً وهذه الصفات تستدعي في ثبوتها الحياة فوجب أن يكون الصانع
حياً وقد نازعوه في تماثل الأشكال وتشابه الأمثال وذلك عناداً وجدال لكن
الخصم يقول نسبة الصنع عندنا إلى الذات كنسبته إلى الإرداة والقدرة عندكم
فإن الإرادة عندكم واحدة وهي في ذاتها صفة صالحة يتأتى بها التخصيص مطلقاً
ونسبتها إلى هذا المثل كنسبتها إلى مثل آخر وكذلك القدرة ولأنهما لا
يتعلقان بالمرادات والمقدورات قبل الإيجاد فما الموجب لتخصيص حال الوجود
بالإيقاع ونسبة الإرادة والقدرة إلى هذه الحال كنسبتها إلى حال أخرى
فجوابكم عن تعلق الصفات بالمتعلقات إيجاداً هو جوابنا عنا نسبة إلى
الموجبات إيجاباً والسؤال مشكل وقد أشرنا إلى حل الإشكال في حدث العالم
وربما يقول الخصم ألستم رددتم معنى كونه حكيماً إلى كونه مريداً أو فاعلاً
على مقتضى العلم ورد الكعبي كونه مريداً إلى كونه قادراً عالماً ورد أبو
الحسين البصري جملة الصفات إلى كونه قادراً عالماً على رأي وإلى كونه
قادراً على رأي وإلى كونه عالماً على رأي فنحن رددنا جملة الصفات إلى كونه
ذاتاً واجبة الوجود على جلال وكمال تصدر منه الموجودات على أحسن نظام
وأتقن أحكام ثم يشتق له اسم من نحو آثاره لذاته أو اسم لذاته أو اسم من
حيث تقدسه عن سمات مخلوقاته ويسمى الأول أسماء إضافية كالعلة والمبدأ
والصانع ويسمى الثاني أسماء سلبية كالواحد والعقل والعاقل والواجب وأشتهي
أن تجري في هذه الأسامي مباحثة عقلية للإنصاف والانتصاف.
فأقول العلة
والمبدأ عندكم يقال على كل ما استمر له وجود في ذاته ثم حصل منه وجود شيء
آخر ويقوم به وقد يكون الشيء علة للشيء بالذات وقد يكون بالعرض وقد تكون
علة قريبة وقد تكون علة بعيدة وواجب الوجود لذاته تام الوجود في ذاته وحصل
منه العقل الأول أهو علة له بالذات أم بالعرض فإن كان علة له بالذات لا
بالعرض فهو مبدأ له بالقصد الأول لا بالقصد الثاني ولم يكن واجب الوجود
غنياً مطلقاً بل فقيراً محتاجاً إلى كسب ولم يكن كاملاً مطلقاً بذاته لولا
معلولة بل كاملاً بغيره ناقصاً باعتبار ذاته كيف وهم يأبون أن يكون
المعلول الأول وسائر الموجودات إلا من لوازم تعقله بذاته فلا يكون توجيه
واجب الوجود الأزلي إلا إلى ذاته على سبيل الاستغناء المطلق عن الكل ووجوه
سائر الموجودات إليه على سبيل احتياج الكل إليه وإن قالوا هو علة بالعرض
لا بالذات مبدأ بالقصد الثاني لا بالقصد الأول قلنا فما لم تكن العلة علة
لشيء بالذات لا تكون علة لشيء آخر بالعرض وما لم يكن مبدأ الشيء بالقصد
الأول لا يكون مبدأ الشيء بالقصد الثاني فيلزم ما لزم في الأول فيبطل
إطلاق لفظ العلة والمبدأ عليه.
ونقول أيضاً كونه مبدأ وعلة لم يدخل
في مفهوم كونه واجباً بذاته فإن مفهوم أنه علة أمر إضافي ومفهوم أنه واجب
بذاته أمر سلبي وقد تمايز الأمران والمفهومان ويدل كل واحد منهما على غير
ما دل عليه الثاني فمن أين يصح لكم رد المعاني إلى أمر واحد وهو الذات
فتمايز المفهومات والاعتبارات عندكم وتمايز الأحوال عند أبي هاشم وتمايز
الصفات عند أبي الحسن على وتيرة واحدة وكلكم يشير إلى مدلولات مختلفة
الخواص والحقائق واعتذاركم أن كثرة اللوازم والسلوب والإضافات لا تقتضي
كثرة في صفات الذات واستشهادكم بالقرب والبعد لا يغني عن هذا الإلزام فإنا
نلزمكم تمايز الوجوه والاعتبارات بين الإضافي والسلبي إذ من المعلوم كونه
علة ومبدأ للمعلول الأول أمر أو حال سلبي وليس يوجب المعلول من حيث أنه
انتفا عنه الكثرة وليس كونه مسلوب الكثرة عنه موجباً للمعلول ولا يلزم
وجوده شيء من حيث يسلب عنه شيء ولا يسلب عنه شيء من حيث يلزم وجوده شيء
ويخالف ما نحن فيه حال القرب والبعد بالإضافة إلى شيء دون شيء فإن قرب
الجوهر من جوهر قد يكون من باب الإضافة وقد يكون من باب الوضع وقد يكون من
باب الأين لكن لفظ القرب والبعد يطلق على كل جوهرين تقارباً أو تباعداً
بمقدار ما والمقادير بينهما لا تنحصر في حد فقيل فعند ذلك تختلف بالنسب
والإضافات وهي لا تنحصر فلو قلنا أنهما أمران زائدان على وجودهما أدى ذلك
إلى إثبات أعراض لا تتناهى لجوهرين متناهيين لكن ما فيه القرب والبعد
متناهيين أعني الأين والوضع والإضافة فهي أمور زائدة على ذاتي الجوهرين
فعرف أن المثال الذي تمثلوا به لازم عليهم.
على أنا نقول ألستم أثبتم
الإضافة معنى وعرضاً زائداً على الجوهر فأفيدونا فرقاً معقولاً بين إضافة
الأب إلى الابن وبين إضافة العلة إلى المعلول فإن الإضافة هو المعنى الذي
وجوده بالقياس إلى شيء آخر وليس له وجود غيره مثل الأبوة بالقياس إلى
النبوة لا كالأب فإن له وجوداً كالإنسانية وكونه مصدراً ومبدأ هو المعنى
الذي وجوده بالقياس إلى المعلول وليس له وجود غيره وكذلك كل علة ومعلول
سوى العلة الأولى فتعرض له هذا المعنى وهو هذا المعنى بعينه ثم حكمتم بأن
الأبوة معنى هو عرض زائد فهلا حكمتم بأن العلية معنى هو عرض زائد حتى يلزم
أن يكون الإيجاب بالذات نوع ولادة.
وكثيراً ما دار في خيالي وخاطري أن
الذي اعتقدوه النصارى من الأب والابن هو بعينه ما قدره الفلاسفة من الموجب
والموجب والعلة والمعلول " تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر
الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً " فهو
تعالى لم يوجِب ولم يوجَب ولم يلد ولم يولد وإنما نسبة الكل إليه نسبة
العبودية إلى الربوبية " إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً
" وهو رب كل شيء ومبدعه وإله كل موجود وفاطره جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا
إله غيره.
القاعدة التاسعة
في إثبات العلم بالصفات الأزلية
صارت المعتزلة إلى أن الباري تعالى حي عالم قادر لذاته لا يعلم وقدرة وحياة واختلفوا في كونه سميعاً بصيراً مريداً متكلماً على طرق مختلفة كما سنوردها مسائل أرفاد إن شاء الله تعالى وأبو الهذيل العلاف انتهج مناهج الفلاسفة فقال الباري تعالى عالم بعلم هو نفسه ولكن لا يقال نفسه علم كما قالت الفلاسفة عاقل وعقل ومعقول.ثم اختلفت المعتزلة في أن أحكام الذات هل هي أحوال الذات أم وجوه واعتبارات فقال أكثرهم هي أسماء وأحكام للذات وليست أحوال وصفات كما في الشاهد من الصفات الذاتية للجوهر والصفات التابعة للحدوث.
وقال أبو هاشم هي أحوال ثابتة للذات وأثبت حالة أخرى توجب هذه الأحوال.
وقالت الصفاتية من الأشعرية والسلف إن الباري تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حي بحياة سميع بسمع بصير ببصر مريد بإرادة متكلم بكلام باق ببقاء وهذه الصفات زائدة على ذاته سبحانه وهي صفات موجودة أزلية ومعان قائمة بذاته.
وحقيقة الإلهية هي أن تكون ذات أزلية موصوفة بتلك الصفات وزاد بعض السلف قديم بقدم كريم بكرم جواد بجود إلى أن عد عبد الله بن سعيد الكلابي خمسة عشر صفة على غير فرق بين صفات الذات وصفات الأفعال.
قالت الفلاسفة واجب
الوجود بذاته لن يتصور إلا واحداً من كل وجه فلا صفة ولا حال ولا اعتبار
ولا حيث ولا وجه لذات واجب الوجود بحيث يكون أحد الوجهين والاعتبارين غير
الآخر أو يدل لفظ على شيء هو غير الآخر بذاته ولا يجوز أن يكون نوع واجب
الوجود لغير ذاته لأن وجود نوعه له لعينه ولا يشاركه شيء ما صفة كانت أو
موصوفاً في وجوب الوجود والأزلية ولا ينقسم هو ولا يتكثر لا بالكم ولا
بالمبادئ المقومة ولا بأجزاء الحقيقة والحد تعم له صفات سلبية مثل تقدسه
عن الكثرة من كل وجه فيسمى لذلك واحداً حقاً أحداً صمداً ومثل تنزهه عن
المادة وتجرده عن طبيعة الإمكان والعدم ويسمى لذلك عقلاً وواجباً وله صفات
إضافية مثل كونه صانعاً مبدعاً حكيماً قديراً جواداً كريماً وصفات مركبة
من سلب وإضافة مثل كونه مريداً أي هو مع عقليته ووجوبه بذاته مبدأ لنظام
الخير كله من غير كراهية لما يصدر عنه وجواداً أي هو بهذه الصفة وزيادة
سلب أي لا ينحو إعراضاً لذاته وأولاً أي هو مسلوب عنه الحدوث مع إضافة
وجود الكل إليه وصفاته عندهم إما سلبية محضة وإما إضافية محضة وإما مؤلفة
من سلب وإضافة والسلوب والإضافات لا توجب كثرة في الذات.
ونحن نسلك
منهاجاً في إنهاء كلام كل صاحب مذهب نهايته على سبيل المناظرة والمباحثة
فتظهر مزلة الإقدام ومضلة الأوهام ويلوح الحق من وراء ستر رقيق على أوضح
تحقيق وتدقيق.
قالت الصفاتية ونحن نعتبر الغائب بالشاهد بجوامع أربعة
وهي العلة والشرط والدليل والحد أما العلة فنقول قد ثبت كون العالم عالماً
شاهداً معلل بالعلم والعلة العقلية مع معلولها يتلازمان ولا يجوز تقدير
واحد منهما دون الآخر فلو جاز تقدير العالم عالماً دون العلم لجاز تقدير
العلم من غير أن يتصف محله بكونه عالماً فاقتضى الوصف الصفة كاقتضاء الصفة
الوصف فمن ثبت له هذه الصفات وجب وصفه بها كذلك إذا وجب وصفه بها وجب
إثبات الصفة له ثم عضدوا كلامهم بالإرادة والكلام فإنه لما ثبت له الإرادة
والكلام كان مريداً متكلماً فلما ثبت كونه مريداً متكلماً وجب له الإرادة
والكلام فإن العلم رسمان لا يختلفان في العلية والمعلولية وإن كانا
يختلفان عندهم في القدم والحدوث.
قالت المعتزلة تعليل الأحكام بالعلل
نوع احتياج إلى العلل وذلك لا يتحقق إلا إذا كان الحكم جائز الوجود وجائز
العدم فيعلل الحكم بجوازه في الشاهد وكون الباري تعالى عالماً واجب وهو
مقدس عن الاحتياج إلى التعليل فلا يعلل الحكم لوجوبه في الغائب أليس كل
حكم واجب في الشاهد غير معلل أصلاً مثل تحيز الجوهر وقبوله للعرض ومثل
قيام العرض بالجواهر واحتياجه إلى المحل إلى غير ذلك وخرجوا عن هذه
القاعدة كونه مريداً فإنه لما لم يكن واجباً كان معللاً وهذا كله لأن
الواجب يستقل بوجوبه عن الافتقار إلى العلة وإنما الجائز لما لم يستقل
بنفسه أعني أحد طرفي جوازه احتاج إلى علة إما اختيار مختار وإما إيجاب علة
فوجود العلم في العالم شاهداً لما كان جائزاً احتاج إلى اختيار مختار
يوجده وثبوت حكم العلة في الشاهد لما كان جائزاً احتاج إلى علة توجبه وهي
العلم أليس وجود القديم لما كان واجباً لم يعلل ووجود الحادث لما كان
جائزاً علل.
قالت الصفاتية بم تنكرون على من يعلل الأحكام الجائزة
بالعلل الجائزة والأحكام الواجبة بالعلل الواجبة فلا الاحتياج والافتقار
غير موجب للتعليل ولا الاستقلال ولا الاستغناء مانع من التعليل لأنا لسنا
نعني بالتعليل الإيجاد والإبداع حتى يستدعيه الجواز والاحتياج ويمنعه
الوجوب والاستغناء لكنا نعني بالتعليل الاقتضاء العقلي والتلازم الحقيقي
بشرط أن يكون أحدهما ملتزماً والآخر ملتزماً والوجوب والجواز لا أثر لهما
في منع الاقتضاء والتلازم فلا يمتنع عقلاً تعليل الواجب بالواجب وتعليل
الجائز بالجائز وزادوا على ذلك تحقيقاً.
فقالوا نحن لا نحكم على
الأحكام من حيث أنها أحكام بأنها جائزة فإنها على مذهب مثبتي الأحوال صفات
لا توصف بالوجود والعدم ولا ذات لها على الانفراد حتى يقال هي جائزة أو
واجبة وعلى مذهب النفاة عبارات عن اختصاصات المعاني بالمحال بحيث يعبر
عنها بالأسامي وهي على المذهبيين لا يطلق عليها الجواز والوجوب من حيث هي
أحكام بل الوجوب إليها أقرب فإنها بالنسبة إلى عللها واجبة سواء قدرت
قديمة أو حادثة فكون العالم عالماً بعد قيام العلم بالمحل ليس بجائز بل
واجب لأنه من حيث هو حكم العلم لا ذات له فلا يتطرق إليه الجواز والإمكان
ومن حيث هو ذو العلم يتطرق إلى ذي العلم الجواز إذ يجوز أن يكون ذا علم
ويجوز أن لا يكون والجواز من هذا الوجه لا يعلل البتة بل ينسب إلى الفاعل
حتى يخصص بأحد طرفي الجواز فهو إذاً من حيث أنه جائز لا يعلل بعلة ولو وجب
تعليل كل جائز بعلة وتلك العلة أيضاً تعلل بعلة فيؤدي إلى ما لا نهاية له
ولست أقول لا ينسب إلى فاعل وأن نسبة الجائز في أن يوجد إلى فاعل ليس
كنسبة العالمية في أن توجب إلى علم فليفرق الفارق بين تعليل الأحكام
بالعلل وبين تعلق المقدور بالقدرة فإن بينهما بوناً عظيماً وأمداً بعيداً
فلا يجوز أن يقتبس حكم أحدهما من الآخر ولا أن يطرد حكم أحدهما في الثاني
إلا أن يمنع مانع أصل التعليل ويرفع العلة والمعلول ولا نقول بهما في
الشاهد والغائب وذلك كلام آخر ومن نفا الحال وكونها صفة ثابتة في الأعيان
لم يصح إثبات العلة والمعلول على أصله تحقيقاً فإنه لم يبق إلا عبارة
أعياناً محضة أو وجه اعتبار عقلي فلا معنى لكون العالم عالماً على أصله
إلا أنه شيء ما له علم وليس العلم يوجب حكماً زائداً على نفسه فيقال أي
شيء يعني بكونه فاعله أهي مقتضية شيئاً أم غير مقتضية وإن اقتضت أهي تقتضي
نفسها أم غيرها فإن اقتضت نفسها فذلك سفسطة وإن اقتضت غيرها أفهو موجود أو
حال أو جهة لا توصف بالوجود والعدم والكلام على الأمرين ظاهر فقد تكلمنا
على ذلك في مسئلة الحال بما فيه مقنع ونقول ها هنا إن سلم مسلم كون العلم
علة العالمية في الشاهد وألزم الطرد والعكس حتى إذا ثبت العلم وجب كون
المحل عالماً وإذا ثبت كون المحل عالماً لزم وجود العلم.
أجاب بأن
الطرد والعكس شاهداً وغائباً إنما يلزم بعد تماثل الحكمين من كل وجه لا من
وجه دون وجه والخصم ليس يسلم تماثل الحكمين أعني عالمية الباري تعالى
وعالمية العبد بل لا تماثل بينهما إلا في اسم مجرد وذلك أن العلمين إنما
يتماثلان إذا تعلقا بمعلوم واحد والعالميتان كذلك ومن المعلوم الذي لا
مرية فيه أن عالمية الغائب وعالمية الشاهد لا يتماثلان من كل وجه بل هما
مختلفان من كل وجه فكيف يلزم الطرد والعكس والإلحاق والجمع أليس لو ألزم
طرد حكم للعالمية في الغائب من تعلقها بمعلومات لا تتناهى وحكم القادرية
في الغائب من صلاحية الإيجاد والتعلق بالمقدورات التي لا تتناهى إلى غاية
حتى يحكم على ما في الشاهد بذلك لم يلزم فلذلك احتياج العالمية في الشاهد
إلى علة لا يستدعي طرده في الغائب فإذاً لا تعويل على الجمع بين الشاهد
والغائب بطريق العلة والمعلول بل إن قام دليل في الغائب على أنه عالم يعلم
قادر بقدرة فذلك الدليل مستقل بنفسه غير محتاج إلى ملاحظة جانب الشاهد.
ومن
الجمع بين الشاهد والغائب الشرط والمشروط قالت الصفاتية ألستم وافقتمونا
على أن الشرط وجب طرده شاهداً وغائباً فإن كون العالم عالماً لما كان
مشروطاً بكونه حياً في الشاهد وجب طرده في الغائب حتى إذا ثبت كونه حياً
بهذا الطريق كذلك في العلم وأنتم ما فرقتم في الشرط بين الجائز والواجب
لذلك يلزمكم في العلم أن لا تفرقوا في العلة بين الجائز والواجب وهذا لازم
على المعتزلة غير أن لهم ولغيرهم طريقاً آخر في إثبات كونه تعالى حياً
بدون الشرط فإن الحياة بمجردها لم تكن شرطاً في الشاهد ما لم ينضم إليها
شرط آخر فإن البنية على أصلهم شرط في الشاهد ثم لم يجب طرده في الغائب
وانتفاء الأضداد شرط حتى يتحقق العلم ويجوز أن يكون المعنى الواحد شرطاً
لمعان كثيرة ويجوز أن تكون شروط كثيرة لمعنى واحد وبهذا يتحقق التمايز بين
الشرط والعلة فلا يلزم الشرط على القوم ولكن يلزم على كل من قال بالعلة
والمعلول والشرط والمشروط سؤال التقدم والتأخر بالذات وإن كانا متلازمين
في الوجود فإن العلة إنما صارت مقتضية للحكم لاستحقاقها التقدم عليه بذاته
والمعلول إنما صار مقتضياً للعلة لاستحقاقه التأخر عنها بذاته وبهذا أمكنك
أن تقول إنما صار العالم عالماً لقيام العلم به ولا يمكنك أن تقول إنما
قام العلم به لكونه عالماً ولو كان حكمهما في الذات حكماً واحداً لم يثبت
هذا الفرق وبمثل هذا نفرق بين القدرة الحادثة والمقدور فإن الاستطاعة وإن
كانت مع الفعل وجوداً إلا أنها قبل الفعل ذاتاً واستحقاق وجود ولهذا أمكنك
أن تقول حصل الفعل بالاستطاعة ولا يمكنك أن تقول حصلت الاستطاعة بالفعل
وهذا قولنا في الشرط والمشروط فإن المحل يجب أن يكون حياً أولاً حتى يقوم
العلم به والقدرة ولا يمكنك أن تقول العلم والقدرة أولاً حتى يكون حياً
وإلا فيرتفع التميز بين الشرط والمشروط.
ولا تظنن أن هذا الفرق راجع
إلى مجرد اللفظ فإن التفرقة المذكورة قضية عقلية وراء اللفظ ولا تظنن
أيضاً أنه راجع إلى تقديرنا الوهمي حيث يقدر استحقاق وجود لأحدهما دون
الثاني وافتقار وجود أحدهما بالثاني فإن كل تقدير وهمي إذا لم يكن معقولاً
أمكن تبديله بغيره من التقديرات وهذا لا يمكن تبديله بل هذه قضية معقولة
فيلزم على ذلك أحد أمرين إما أن يترك القول بالعلة والمعلول والشرط
والمشروط رأساً ولا يطلق لفظ الإيجاب والاقتضاء على المعاني بل يقال معنى
كون الشيء عالماً قيام العلم به ومعنى قيام العلم به اتصاف محله به من غير
فرق لكن يشتق له اسم من العلم فيقال عالم كما يشتق له اسم من الفعل فيقال
فاعل وهذا أمر راجع إلى اللغة فحسب فلا اقتضاء ولا إيجاب ولا علة ولا
معلول وهذا أهون الأمرين وإما أن يقضي بسبق العلم على العالمية وأن يكون
الوجود بالعلم أولاً وأولى منه بالعالمية ثم يحكم بسبق الذات على الصفات
وأن يكون الوجود بالذات أولاً أولى منه بالصفات من حيث أن الذات قائمة
بذاتها والصفات قائمة بها حتى يكون الموصوف من حيث الذات أسبق على الصفة
والصفة من حيث الإيجاب والاقتضاء أسبق على الموصوف وهذا أشنع الأمرين
والاستخارة إلى الله سبحانه وتعالى وهو خير مخير.
ومن الجوامع بين
الشاهد والغائب الحد والحقيقة جرى رسم المتكلمين بذكر الحد والحقيقة في
هذا الموضع وقد اختلفوا في أن الحد عين المحدود أو غيره وأنه والحقيقة شيء
واحد أم شيئان.
قال نفاة الأحوال حد الشيء وحقيقته وذاته وعينه عبارات عن معبر واحد.
وقال
مثبتو الأحوال أن الحد قول الحاد المبين عن الصفة التي تشترك فيها آحاد
المحدود فإن المحدود عندهم يتميز عن غيره بخاصية شاملة لجميع آحاد المحدود
وتلك الخاصية حال ويعبر عن تلك الحال بلفظ شامل دال عليه جامع مانع يجمع
ما له من الخاصية ويمنع ما ليس له من خواص غيره ثم من الأشياء ما يحد
ومنها ما لا يحد على أصلهم وأكثر حدود المتكلمين راجع إلى تبديل لفظ بلفظ
أعرف منه وربما يكون مثله في الخفا والجلا وإنما أهل المنطق يبالغون في
ذكر شروط الحد ويحققون في استيفاء جوانبه لفظاً ومعنى غير أنهم إذا شرعوا
في تحديد الأشياء وتحقيق ماهياتها يأتون بأبعد ما يأتي به المتكلمون كمن
يتقن علم العروض ولا طبع له في الشعر أو كمن يكون له طبع ولا مادة له من
النحو والأدب فيعود حسيراً ويصبح أسيراً ولعلهم معذورون لأن الظفر
بالذاتيات المشتركة والذاتيات الخاصة عسير جداً.
فنقول في تحديد الحد
وشرائطه أن الحد ينقسم إلى ثلاثة معان حد لفظي هو شرح الاسم المحض كمن
يقول حد الشيء هو الموجود والحركة هي النقلة والعلم هو المعرفة وليس يفيد
ذلك إلا تبديل لفظ بما هو أوضح منه عند السائل على شرط أن يكون مطابقاً له
طرداً وعكساً.
وحد رسمي وهو تعريف الشيء بعوارضه ولوازمه كمن يقول حد
الجوهر القابل للعرض وحد الجسم هو المتناهي في الجهات القابل للحركات وقد
يفيد هذا القول نوع وقوف على الحقيقة من جهة اللوازم وقد لا يفيد.
وحد
حقيقي هو تعريف لحقيقة الشيء وخاصيته التي بها هو ما هو وإنما هو ما هو
بذاتيات تعمه وغيره وبذاتيات تخصه والجمع والمنع إن أريد بهما هذان
المعنيان فهو صحيح فيما يجمعه من الذاتيات العامة والخاصة وهو الجنس
والفصل وما يمنع غيره فيقع من لوازم الجمع والطرد والعكس يقع أيضاً من
اللوازم.
ومن شرائطه أنه يجب أن يكون أعرف من المحدود ولا يكون مثله
ولا دونه في الخفاء والجلاء وأن لا يعرف الشيء بما لا يعرف إلا به إلى غير
ذلك فيما ذكر فإذا ثبت ما ذكرناه من تحديد الحد بعد التفصيل.
قال من
حاول الجمع بين الغائب والشاهد بالحد والحقيقة حد العالم في الشاهد أنه ذو
العلم والقادر ذو القدرة والمريد ذو الإرادة فيجب طرد ذلك في الغائب
والحقيقة لا تختلف شاهداً أو غائباً قيل له هذا تعريف الشيء بما هو دونه
في الخفاء والجلاء فإن الإنسان ربما يعرف كون زيد متحركاً ويشك في الحركة
حتى يبرهن على ذلك وكذلك في جميع الأوصاف فكيف اقتبست معرفة الإجلاء من
الإخفاء وأيضاً فإن ذا الشيء قد يكون على سبيل الوصف والصفة وقد يكون على
سبيل الفعل والمفعول وقد يكون على سبيل الملك والمملوك أليس روي في
التنزيل " رفيع الدرجات ذو العرش " ثم العرش خلقه وملكه وليس صفة قائمة
بذاته فما أنكرتم أن يكون معنى كونه ذا العلم والقدرة.
قال قد يقتبس إثبات العلم والقدرة من كونه عالماً وقادراً وقد يقتبس من
كون الشيء معلوماً ومقدوراً.
فبقول المتعلق بالمعلوم علم والمتعلق بالمقدور قدرة فإذا قام الدليل على
كونه عالماً بالمعلوم فيجب أن يكون عالماً بالعلم.
ويحققه
أن العلم إحاطة بالمعلوم ويستحيل أن تكون الذات محيطاً أو متعلقاً فيجب أن
يكون للذات صفة إحاطة هي المحيطة المتعلقة بالمعلومات.
قالت المعتزلة
معلوم الله بكونه عالماً لا بالعلم ولا بالذات ولا معنى لكون المعلوم
معلوماً إلا أنه غير مخفي على العالم كما هو عليه فليس ثم تعلق حسي أو
وهمي حتى يحال به على العلم أو على الذات وقولكم العلم إحاطة بالمعلوم
تغيير عبارة وتبديل لفظ بلفظ وإلا فالعلم والإحاطة والتيقن عبارات عن معبر
واحد ومعنى كون الذات عالماً أنه محيط وكذلك معنى كونه محيطاً أنه عالم
وإنما وقعتم في إلزام لفظ الإحاطة لظنكم أن الإحاطة لو تحققت للذات كانت
تلك الإحاطة كإحاطة جسم بجسم وذلك الاشتراك في اللفظ وإلا فمعنى الإحاطة
هو العلم " وهو بكل شيء عليم " محيط وبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير.
قالت
الصفاتية العقل الصريح يفرق بين كون الشيء معلوماً وبين كونه مقدوراً وكيف
لا وكونه معلوماً أعم من كونه مقدوراً فإن المعلوم قد يكون قديماً وقد
يكون حادثاً وواجباً وجائزاً ومستحيلاً وكونه مقدوراً ينحصر في كونه
ممكناً جائزاً ثم نسبة المعلوم إلى الذات من حيث هي ذات واحدة كنسبة
المقدور من حيث هي ذات.
فنقول نسبة الذات إليهما على قضية واحدة
عندكم أم تختلف النسبة فإن كان نسبة الذات إليهما على قضية واحدة فيلزم أن
لا يكون أحدهما أعم والثاني أخص ويجب أن يكون كل معلوم مقدوراً كما كان كل
مقدور معلوماً وإن اختلف وجه النسبة بالأعم والأخص علم أنه كل كان مضافاً
إلى الذات بل إلى صفة وراء الذات وذلك مما يخبر عنه التنزيل بالعلم
والقدرة.
قالت المعتزلة تختلف وجوه الاعتبارات في شيء واحد ولا يوجب
ذلك تعدد الصفة كما يقال الجوهر متحيز وقائم بالنفس وقابل للعرض ويقال
للعرض لون وسواد وقائم بالمحل فيوصف الجوهر والعرض بصفات هي صفات الأنفس
التي لا يعقل الجوهر والعرض دونهما ثم هذه الأوصاف لا تشعر بتعدد في الذات
ولا بتعدد صفات هي ذوات قائمة بالذات ولا بتعدد أحوال ثابتة في الذات كذلك
نقول في كون الباري تعالى عالماً قادراً.
قالت الصفاتية ليس في وصف
الجوهر والعرض بهذه الأوصاف أكثر من إثبات حقيقة واحدة لها خاصية تتميز
بها عن غيرها وهذه العبارات دالة على تلك الخاصية وهي الحجمية في الجوهر
والسوادية في العرض مثلاً فأما تحيزه وقبوله للعرض فذلك تعرض لنسبة الجوهر
إلى الحيز ونسبته إلى العرض إما تقديراً أو تحقيقاً وبمثل ذلك نقول في حق
الباري سبحانه أنه موجود قديم قائم بنفسه غني أحد صمد غير متناهي الوجود
والذات وكل هذه الأوصاف ترجع إلى حقيقة واحدة وأما وصفه بكونه حياً عالماً
قادراً إنما هو راجع إلى حقائق مختلفة وخواص متباينة تختص كل صفة بخاصية
وحقيقة لا تتعداها ولكل واحدة فائدة خاصة تخصها ودليل خاص يدل عليها
ومتعلق خاص يختص بها والحقائق إذا اختلفت من هذه الوجوه فقد اختلفت في
ذواتها ولا يسد أحدهما مسد الآخر والعقل إنما يميز هذه المعاني بهذه
الوجوه وإلا فإعراض متعددة إذا قامت بمحل واحد لم يحكم العقل باختلافها
وتعددها إلا باختلاف خواصها وآثارها وفوائدها ودلائلها ومتعلقاتها ومن
المستحيل في العقل اجتماع خواص مختلفة في حقيقة واحدة فلو جاز إثبات ذات
لها حكم العلم والقدرة والإرادة والحياة لجاز إثبات حقيقة واحدة لها حكم
العرض والجوهر ولجاز إثبات علم له حكم القدرة ولجاز إثبات لون له حكم
الكون ويلزم على ذلك اجتماع المتضادات وذلك من أمحل ما يتصور.
ومما
يوضح ذلك وهو أقوى ما يتمسك به في إثبات الصفات قولنا الله عالم قادر وقول
المعطل مثلاً ليس بعالم ولا قادر إثبات ونفى لا محالة فلا يخلو الأمر فيه
إما أن يرجع الإثبات والنفي إلى الذات وإما أن يرجع إلى الصفات وإما أن
يرجع إلى الأحوال ومستحيل رجوعهما إلى الذات فإنها معقولة دون الاتصاف
بالعالمية إذ ليس من ضرورة العلم كونه ذاتاً قائماً بالنفس مستغنياً من كل
وجه أن يعلم كونه عالماً ولذلك كان الدليل على كونه قائماً بالنفس غير
الدليل على كونه عالماً قادراً ولا من ضرورة نفي العالمية نفي الذات فإن
جماعة من المعطلة نفوا كونه عالماً وقادراً مع إقرارهم وعلمهم بثبوت الذات
ويستحيل رجوعهما إلى الحال فإنها لا تنفي على حيالها ولا تثبت وقد أبطلنا
القول بالحال فلم يبق إلا القسم الأخير وهو الرجوع إلى الصفات.
قالت
المعتزلة أنتم أول من أثبت حقائق مختلفة وخواص متباينة لذات واحدة حيث
قلتم الرب تعالى عالم بعلم واحد يتعلق بجميع المعلومات ومن المعلوم أن
العلم بالسواد مثلاً ليس يماثل العلم بالبياض بل يخالفه لأن المثلين عندكم
لا يجتمعان وقد يجتمع العلمان المختلفان فعلمه سبحانه في حكم علوم مختلفة
وكذلك القدرة الأزلية تتعلق بمقدورات لا تتعلق القدرة الحادثة بها فهي في
حكم قدر مختلفة وكذلك الإرادة والسمع والبصر وأظهر من ذلك كله الكلام فإنه
صفة واحدة أزلية وهي في ذاتها أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد ومعلوم
أن هذه حقائق مختلفة قد ثبتت لكلام واحد فإن قلتم هذه الحقائق ترجع إلى
الوجوه والاعتبارات فنحن نقول كذلك في ذات الباري سبحانه وإن رددتم ذلك
إلى الأحوال فمن مذهب أبي هاشم أنها أحوال وعلى كل وجه قدرتموه يلزمكم
مثله في الذات والصفات وقولكم إن المعاني إنما تتعرف بعددها من خواصها
ومتعلقها وآثارها وأدلتها صحيح في الشاهد غير مسلم في الغائب بل بإجماع
منا في مسائل وانفراد منكم في مسائل خالفنا هذه القاعدة فإن القدم والوجوب
بالذات والوحدة والقيام بالذات والبقاء والديمومية وإنه أول وآخر وظاهر
وباطن منزه عن المكان مقدس عن الزمان حقائق مختلفة لو اعتبرناها شاهداً
لكان لكل واحدة منها دليل خاص يدل عليه ومع ذلك لا يوجب تعدداً في الصفات
بالاتفاق وعندكم الأمر والنهي في الشاهد يتباينان ويتضادان وما يدل على
الأمر غير ما يدل على النهي وكذلك الخبر والاستخبار يتمايزان من حيث
الحقيقة والدليل والمتعلق فإن متعلق الأمر غير متعلق الخبر والخبر يتعلق
بالقديم والأمر لا يتعلق به واختلافهما من حيث التعلق أوجب اختلافهما في
الشاهد ثم لم نستدل باختلافهما في الشاهد على اختلافهما في الغائب بل
كلامه أمر ونهي مع أن الأمر يتعلق بالمأمورات دون المنهيات والنهي يتعلق
بالمنهيات دون المأمورات والخبر يتعلق بكل ما يتعلق به العلم معدوماً
وموجوداً وواجباً وجائزاً ومستحيلاً.
وأما استدلالكم بطريق النفي
والإثبات على أصل نفاة الأحوال غير مستقيم فإن عندهم النفي والإثبات في كل
شيء يرجعان إلى أمر مخصوص معين فلا يتصور إثبات ذات على الإطلاق إلا في
مجرد اللفظ أو يرجع إلى وجه واعتبار فقولنا عالم يرجع إلى العلم بذات على
وجه واعتبار وعند مثبتي الأحوال قولنا عالم يرجع إلى إثبات ذات على حال
كونه عالماً هذا كمن يعرف بكونه موجوداً ولا يعرف بكونه واحداً وغنياً
وقديماً أليس النفي والإثبات في ذلك لا يرجع إلى الصفات الزائدة على الذات
وإنما يرجع إلى الاعتبارات والوجوه كذلك نقول في الصفات فبطل استدلالكم
بالنفي والإثبات.
قالت الصفاتية العلم من حيث هو علم حقيقة واحدة وليس
خاصية واحدة وإنما تختلف العلوم باعتبار متعلقاتها وتتماثل باتحاد المتعلق
وليس يخرج ذلك الاعتبار نفس العلم عن حقيقة العلمية حتى لو قدرنا تقديراً
لمحال جواز بقاء العلم الحادث لتعلق العلم الحادث بمعلومين ومعلومات.
والسر
فيه أن العلم على كل حال يتبع المعلوم عدماً ووجوداً فلا يكسب المعلوم صفة
ولا يكتسب عنه صفة فالعلوم تختلف في الشاهد لاستحالة البقاء وتقدير اختلاف
المتعلقات والعلم القديم في حكم علوم مختلفة لا في حكم خواص متباينة وكذلك
نقول في الكلام فإن الأمر والنهي والخبر والاستخبار شملتهما حقيقة الكلام
فاجتمعت في حقيقة واحدة واختلفت اعتبارات تلك الحقيقة بالنسبة إلى
المتعلقات وهذا غير مستبعد وإنما المستحيل كل الاستحالة إثبات ذات واحدة
لها خاصية العلم وخاصية القدرة والإرادة إلى غير ذلك من سائر الصفات حتى
يلزم أن يقال يعلم من حيث يقدر ويقدر من حيث يعلم ويقدر بعالمية ويعلم
بقادرية وتجتمع صفتان وخاصيتان لذات واحدة وذلك غير معقول وأما صفات الذات
التي ليست وراء الذات فإنها راجعة إلى النفي لا إلى الإثبات فمعنى كونه
قديماً أنه لا أول له ولا آخر ومعنى كونه واحداً أنه لا شريك له ولا قسيم
ومعنى كونه غنياً أنه لا حاجة له ولا فقر ومعنى كونه واجباً بذاته أن
وجوده غير مستفاد من غيره ومعنى كونه قائماً بنفسه أنه غير محتاج إلى مكان
وزمان بل هو مستغن على الإطلاق عن الموجد والمكان والمحل بخلاف قولنا أنه
عالم قادر فإن العالم ذو العلم حقيقة والقادر ذو القدرة حقيقة والإحكام
والإتقان دليل العلم وأثره والوجود والحصول دليل القدرة وأثرها فهما
معنيان معقولان بحقيقتهما فلا يتحدان في ذات كما لا يتحدان بذاتهما حتى
يكون حقيقة أحدهما حقيقة الثاني وكذلك قلتم معاشر المعتزلة أن العالمية
ليس بعينها معنى القادرية لجواز العلم بأحدهما مع الجهل بالثاني.
وقال
أبو هاشم العالمية حال والقادرية حال ومفيدهما حال يوجب الأحوال كلها فلا
فرق في الحقيقة بين أصحاب الأحوال وبين أصحاب الصفات إلا أن الحال متناقض
للصفات إذ الحال لا يوصف بالوجود ولا بالعدم والصفات موجودة ثابتة قائمة
بالذات ويلزمهم مذهب النصارى في قولهم واحد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية
ولا يلزم ذلك التناقض مذهب الصفاتية.
وأما الاستدلال بالنفي والإثبات
فصحيح واعتراضكم فاسد فنقول قد قام الدليل على كون الصانع عالماً قادراً
فلا يخلو الحال إما أن يكون الاسمان عبارتين عن معبر واحد من غير تفاوت
أصلاً فيلزمكم أن تفهم العالمية بفهم القادرية ويلزمكم أن تنفى العالمية
من نفي القادرية ويلزمكم أن يوجد العالم من حيث كونه عالماً فحسب ولا
يحتاج إلى إثبات كونه قادراً فيلزم أن يدل على العالمية كما يدل على
القادرية ومن المعلوم الذي لا مرية فيه أنه ليس إطلاق لفظ العالم القادر
كإطلاق لفظ الموجد الخالق فإنا ندرك ببدائه عقولنا فروقاً ضرورية بين كونه
علاماً قادراً وبين كونه موجداً خالقاً فلو كان الاسمان مترادفين ترادف
هذين الاسمين لكنا لا ندرك بعقولنا هذه التفرقة ثم ليس يجوز أن يقال أحد
الوصفين وصف إثبات والثاني وصف نفي فإنهما في محل تصور الفهم متساويان
وليس يجوز أن يقال أحدهما وصف إضافة والثاني وصف حال وصفة إذ الإضافة من
لوازمها لذاتها بل هما حقيقتان تعرض لهما الإضافة إلى المتعلقات والإضافة
معنى لا تعرض له الإضافة وإذا بطلت هذه الوجوه تعين أنهما صفتان قائمتان
بالذات عبر الشرع عن إحداهما بالعلم وعن الثانية بالقدرة.
قالت
المعتزلة نحن لا ننكر الوجوه والاعتبارات العقلية لذات واحدة ولا نثبت
الصفات إلا من حيث تلك الوجوه إما إثبات صفات هي ذوات موجودات أزلية قديمة
قائمة بذاته هو المنكر عندنا فإنها إذا كانت موجودات وذوات وراء الذات
فإما أن تكون عين الذات وإما أن تكون غير الذات فإن كانت عين الذات فهو
مذهبنا وبطل قولكم هي وراء الذات وإن كانت غير الذات فهي حادثة أو قديمة
وليس من مذهبكم أنها حادثة وإن كانت قديمة فقد شاركت الذات في القدم
والوجوب بالذات ونفى الأولية فهي آلهة أخرى فإن القدم أخص وصف القديم
والاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في الأعم.
ومن الإلزامات على قولكم
أنها قائمة بذاته أن القائم بالشيء محتاج إلى ذلك الشيء حتى لولاه لما
تحقق له وجود به فيلزمكم إثبات خصائص الأعراض في الصفات فإن العرض هو
المحتاج إلى محل يقوم به ويلزمكم إثبات التقدم والتأخر الذاتي العقلي في
الذات والصفات وهذا كله محال.
وساعدهم جماعة من الفلاسفة المعطلة في
إلزام هذه الكلمات وزادوا عليهم بأن قالوا قام الدليل على أن واجب الوجود
مستغن على الإطلاق من كل وجه فمن أثبت له صفة لذاته أزلية معنىً وحقيقة
قائمة بذاته فقد أبطل الاستغناء المطلق من الصفة والموصوف جميعاً وأثبت
الاحتياج والفقر في الصفة والموصوف جميعاً أما الصفة فاحتاجت في وجودها
إلى ذات تقوم بها إذ يدب أن تقول قام العلم بالباري واستحال أن تقول قام
الذات بالعلم وأما الموصوف فإنما يتم كما له في الإلهية إذا قامت به هذه
الصفات حتى لولاها لما كان إلاهاً مستغنياً على الإطلاق فإذاً المستغنى
على الإطلاق لا يكون إلا واحداً من كل وجه ولا كثرة فيه من وجه.
قالت
الصفاتية كما أنكرتم إثبات صفات أزلية أنكرنا عليكم إثبات موصوف بلا صفة
إنكاراً بإنكار واستبعاداً باستبعاد وتقسيمكم أنها عين الذات أم غير الذات
إنما يصح إذا كان التقسيم دائراً بين النفي والإثبات فإن من قال هذا عينه
وهذا غيره قد يعني به أنهما شيئان فهذا شيء وذاك شيء آخر وقد يعني به
أنهما شيئان ويجوز وجود أحدهما مع عدم الثاني أو مع تقدير عدم الثاني ونحن
لا نسلم أن الصفات أغيار ولا نقول أنها عين الذات لأن حد الغيرين عندنا هو
المعنى الثاني لا المعنى الأول ثم إن جاز لمثبتي الأحوال القول بأن الحال
لا موجودة ولا معدومة جاز لمثبتي الصفات القول بأن الصفات لا عين الذات
ولا غير الذات على أن كل حقيقة التأمت من أمرين محققين في الشاهد مثل
الإنسانية فإنها التأمت من حيوانية وناطقية عند القوم فإذا قيل الناطقية
عين الإنسانية أو غيرها لم يصح بأنها لا عينها ولا غيرها وكذلك جزء كل شيء
لا عينه ولا غيره ثم هب أنا نسلم الغيرية بالمعنى الأول فقولكم إن كانت
قديمة أوجب أن تكون إلاهاً دعوى مجردة بل هو محل النزاع وقولكم القدم هو
أخص وصف الإله دعوى لا برهان عليها فإن معنى الإلهية هو ذات موصوفة بصفات
الكمال فكيف نسلم أن كل صفة أزلية إلاه ثم من قال القدم أخص الأوصاف فيجب
أن يبين أعم الأوصاف فإن الأخص إنما يتصور بعد الأعم فما الأعم فإن كان
الوجود هو الأعم والقدم هو الأخص فقد التأمت حقيقة الإلهية من أعم وأخص
فالأخص عين الأعم أو غيره ويلزم على مساق ذلك ما ألزمتموه على الصفات.
وأما
قولكم أن الصفات لو قامت بذاته تعالى لاحتاجت إليها وكان حكمها حكم
الأعراض وكان وجود الموصوف أسبق وأقدم بالذات على وجود الصفة فهذا مما
يستحق أن يجاب عنه.
فنقول معنى قولنا الصفات قامت به أنه سبحانه يوصف
بها فقط من غير شرط آخر والوصف من حيث هو وصف لا يستدعي الاحتياج
والاستغناء ولا التقدم ولا التأخر فإن الوصف بكونه قديماً واجباً بذاته من
حيث هو وصف لا يستدعي كون القدم والوجوب محتاجاً إلى الموصوف ولا كون
الموصوف سابقاً بالقدم والوجوب بل الاحتياج إنما يتصور في الجواهر
والأعراض حيث لم تكن فكانت فاحتاجت إلى موجد لجوازها وتطلق على الأعراض
خاصة حيث لم تعقل إلا في محال واحتاجت إلى محل وبالجملة الاحتياج إنما
يتحقق فيما يتوقع حصوله فيترقب وجوده ولن يتصور الاحتياج في القدم.
وأما
الجواب عن قول الفلاسفة أنه تعالى مستغن على الإطلاق قيل الاستغناء من حيث
الذات أنه لا يحتاج إلى مكان ومحل والاستغناء من حيث الصفات أنه لا يحتاج
إلى شريك في القدرة والفعل ومعين في العلم والإرادة ووزير في التصرف
والتدبير فهو تعالى مستغن على الإطلاق وإنما يستغني بكمال صفاته وصفات
جلاله فكيف يقال أنه احتاج إلى ما به استغنى أليس القول بأنه استغنى
بوجوبه في وجوده عن موجد ولا يقال أنه لما استغنى عند ذلك كان محتاجاً
إليه كذلك نقول إنه استغنى بذاته وصفاته فلا الموصوف محتاج إلى الصفة ولا
الصفة احتاجت إلى الموصوف وإنما يتحقق الاحتياج أن لو كانت الصفة على مثال
الآلة والأداة والصفات الأزلية يستحيل أن تكون آلة فبطل الإلزام وزال
الإيهام.
قالت الفلاسفة القسمة الصحيحة العقلية أن الموجود ينقسم
إلى واجب بذاته وإلى ممكن بذاته وواجب بغيره فالواجب بذاته ليس يتصور إلا
واحداً من كل وجه لا كثرة فيه بوجه من الوجوه لا كثرة أجزاء عددية ولا
كثرة معان عقلية وإلا فيلزم أن يشترك في وجوب الوجود وينفصل كل واحد عن
صاحبه بفصل يخصه فحينئذ تتركب ذاته من جنس وفصل ثم تكون الأجزاء مقومات
للجملة لا محالة والمقوم أقدم من المقوم وما يقوم بالشيء لا يكون واجباً
بذاته بل بالمقوم والواجب بذاته لن يتصور إلا واحداً والمعاني التي
أثبتموها إما أن تكون واجبة بذاتها فيلزم أن يكون اثنان واجبا الوجود وذلك
محال كما قدمناه وإما أن لا تكون واجبة بذاتها بل يكون قوامها بالذات
فيلزم ما ذكرناه آنفاً.
قيل لهم قسمة الوجود إلى واجب بذاته وإلى واجب
بغيره دليل قاطع على نقص إلزامكم فإن الوجود من حيث هو وجود قد عم الواجب
والجائز والوجوب من حيث هو وجوب قد خص الواجب فاشتركا في الأعم وافترقا في
الأخص وما به عم غير ما به خص فتركبت الذات من وجود عام ووجوب خاص فهو
كتركيب الذات من واجب الذات قد شملت الواجبين ويفصل كل واحدهما بفصل عن
الواجب الآخر.
قالت الفلاسفة الوجود ليس يعم القسمين بالسوية بل هو في
أحدهما بالأولى والأول وفي الثاني بلا أولى ولا أول فلم يكن جزا مقوماً
فلم يصلح أن يكون جنسياً فلم يلزم التركيب منه والتقوم به.
قيل هذا
بعينه في الوجوب جوابنا فإن الوجوب ليس يعم القسمين بالسوية فلم يكن
الوجوب جزا مقوماً فلم يصلح أن يكون جنساً فلم يلزم التركيب منه والتقوم
به.
قالت الفلاسفة الوجوب معنى سلبي معناه أن وجوده غير مستفاد من غيره فلم
يصلح أن يكون فصلاً للوجود.
قيل
وإذا لم يصلح أن يكون فصلاً لكونه معنى سلبياً فلا يصلح أن يكون جنساً
لكونه معنى سلبياً وألزمتمونا كونه جنساً إذ قلنا ذاته تعالى واجبة لذاتها
وصفاته تعالى واجبة لذاتها أيضاً بمعنى أن وجودها غير مستفاد من غيرها فلم
لا يجوز أن يكون اثنان كل واحد واجب الوجود لذاته فإن ألزمتمونا بالاشتراك
في شيء والافتراق في شيء آخر لزمكم في الوجوب والوجود كذلك.
قالت
الفلاسفة الوجود يطلق على الموجودات بالتشكيك لا بالتشريك ولا بالتواطؤ إذ
معناه أنه وإن عم إلا أن عمومه ليس بالتسوية فإنه في الواجب لذاته وبذاته
فهو أولى وأول وفي الجائز لغيره وبغيره فهو لا أولى ولا أول فلم يصلح أن
يكون جنساً فلم يلزم منه التركيب من جنس وفصل بخلاف موجودين واجبين كل
واحد منهما وجوبه بذاته وينفصل كل واحد منهما عن الآخر بفصل ذاتي كالعلمية
فإنها والذات تشتركان في وجوب الوجود وينفصل أحدهما عن الآخر بفصل ذاتي
وكذلك العلم والقدرة المشتركان في كونهما معنيين متباينين ثابتين أزليين
وينفصل أحدهما عن الآخر بفصل ذاتي فتكون الإلهية حقيقة ما متركبة من ذات
قائمة بنفسها وصفات مختلفة قائمة بالذات فلا يوجد فرق بين الإنسانية
المركبة من الحيوانية والناطقية وبين الإلهية المركبة من الذات والصفات
وحينئذ لا فرق بين التأليف المحسوس والتأليف المعقول.
قيل لهم أنتم وضعتم هذه الاصطلاحات حيث ضاق بكم التزام الوجود وشموله.
فنقول
العموم إذا حصل معنى مفهوم من لفظ متصور في ذهن كان شموله بالسوية لست
أقول شموله بالنسبة إلى سائر الموجودات بل أقول شموله بالنسبة إلى قسمية
الأخصين به وهو الوجوب والجواز والقول بأنه في الواجب أولى وأول تفسير
لمعنى الواجب أي هو ما يكون الوجود له أولى وأول حتى لو تركنا لفظ الواجب
جانباً وقلنا الوجود ينقسم إلى ما يكون الوجود له أولى وأول وإلى ما يكون
الوجود له لا أولى ولا أول كان التقسيم صحيحاً مفيداً لفائدة الأولى ثم
الوجوب لا يفهم إلا وأن يفهم الوجود أولاً حتى لو رفع الوجود في الوهم
ارتفع الوجوب بارتفاعه وهو معنى ذاتي فالوجود ذاتي للواجب بهذا المعنى
وبمعنى أنه أولى به وأنه لذاته وبذاته وأنه لغيره على خلاف ذلك.
ومن
العجب أنهم قالوا الوجوب معنى سلبي حتى لزمهم أن يقولوا الجواز الذي في
مقابلته معنى إيجابي وليت شعري كيف يستجيز العاقل من عقله أن يرد معنى
الوجوب إلى السلب والجواز إلى الإيجاب أليس الوجود أولى بالواجب فكيف صار
أولى بالجائز أليس الوجوب تأكيداً للوجود فكيف تأكد الوجوب بالسلب وهل هذا
كله إلا تحير العقل ودوار في الرأس وتطرق الوسواس إلى صدور الناس.
ثم
نقول إن سلم لكم أن الوجود ليس بجنس فلم يخرج عن كونه عاماً شاملاً
للقسمين إذ لولا شموله وإلا لما صح التقسيم فإن التقسيم إنما يرد على
المعنى لا على مجرد اللفظة فالمعنى العام للواجب والجائز غير المعنى الخاص
بأحد القسمين فإذا لم يكن التركيب تركباً من جنس وفصل كان تركباً من عام
وخاص فيفيد أحدهما من التصور ما لا يفيده الآخر فيلزم منه عين ما يلزم من
الفصل والجنس.
قالت الفلاسفة التميز بينهما تميز في الذهن بالاعتبار العقلي لا في الوجود.
قيل
لهم التميز بين العرضية واللونية تميز في الذهن بالاعتبار العقلي لا في
الوجود وكذلك الإنسانية في كونها مركبة من حياة ونطق فما الفرق بين وجود
عام ووجوب خاص وبين عرض عام ولون خاص والتركيب كالتركيب إلا أن أحد
العامين والخاصين من جنس وفصل على اصطلاح المنطق فيصلح أن يركب منهما حد
الشيء والثاني عام وخاص لا يصلح أن يركب منهما حد الشيء والفرق من هذا
الوجه ليس يقدح في غرضنا من الإلزام فإنا لم نلزم كون الباري تعالى
محدوداً بل ألزمنا كونه موصوفاً والموصوف بالصفة أعم من المحدود بالحد ثم
القول بأن تركبه بالقياس إلى عقولنا وأذهاننا تسليم المسئلة وزيادة أمر
على الصفاتية ويلزم عليه أن يقال له مادة وجنس وفصل وخاصية وعرض إلى غير
ذلك من أنواع التركيب بالقياس إلى عقولنا لا بالقياس إلى ذاته ثم هم معرفة
المعلوم على خلاف ما هو له فإنه في ذاته غير مركب وفي التصور العقلي مركب
ثم الوجوب إن كان معنىً إثباتياً في الذهن غير إثباتي في الخارج فذلك
تغيير حقيقة الشيء الواحد بالنسبة إلى شيئين والحقائق لا تختلف بالنسبة
أصلاً وإن كان الوجوب معنى سلبياً في الذهن فقد استغنى بكونه نفياً عن
إلزام التركيب الذهني وعندهم المعاني السلبية لا توجب التكثير سواء كانت
في الذهن أو في الخارج والمعاني الإيجابية الغير إضافية لا تخلو من التكثر
سواء كانت في الذهن أو في خارج ومن المعلوم أنا إذا قلنا يعلم ذاته ويعلم
غيره فليس علمه بذاته علماً بغيره من الوجه الذي كان علماً بذاته بل
اعتبار علمه بذاته غير اعتبار علمه بغيره واعتبار إضافة العقل الأول إليه
عندكم غير اعتبار إضافة العقل الثاني إليه وإذا اختلفت الاعتبارات والوجوه
العقلية لزمكم التكثير في الذات فنحن نسمي كل اعتبار صفة وما سميتموه
بالمعاني السلبية فعندنا القدم والوحدة بمثابتهما فإن معنى القديم أنه لا
أول لوجوده ومعنى الواحد أنه لا انقسام لذاته وما سميتموه من المعاني
بالمعاني الإضافية فعندنا كونه خالقاً رزاقاً بمثابتهما فإن معنى الخالقية
يتصور من الخلق والرازقية من ارزق وبقي عندنا أنا أثبتنا معاني من كونه
عالماً قادراً حياً فإن رده إلى السلبية غير ممكن حتى يقال معنى كونه
عالماً أنه غير جاهل فإن غير الجاهل قد يتصور ولا يكون عالماً فهو أعم
وحتى يقال أن معنى كونه قادراً أنه غير عاجز فإن غير العاجز قد يتصور ولا
يكون قادراً فنفي الأولية بالضرورة يقتضي القدم ونفي الانقسام لا يقتضي
العلم والقدرة فقد يخلو الشيء عن الجهل والعلم كالجماد فإذاً معنى
العالمية والقادرية ليس معنىً سلبياً وليس هو أيضاً معنى إضافياً فإن
الاسم الإضافي من المضاف يتلقى بمعنى أنه يحصل الفعل أولاً حتى يسمى
فاعلاً وليس كذلك كونه عالماً قادراً فإن وجود المعلوم والمقدور من العلم
والقدرة يحصل فهو على خلاف وضع الأسامي الإضافية خصوصاً على أصلهم فإنهم
قالوا علمه تعالى فعلى لا انفعالي وعند المتكلمين العلم يتبع المعلوم
وعندهم المعلوم يتبع العلم والمقدور يتبع القدرة وعن هذا قالوا إنما يصدر
عنه العقل الأول لعلمه بذاته فإذا لم يكن العلم معنى سلبياً ولا معنى
إضافياً ولا مركباً منهما فتعين أنه صفة للموصوف.
قالت الفلاسفة
المبدأ الأول يعقل ذاته ويعقل ما يلزم ذاته وعقله لذاته من حيث أنه مجرد
عن المادة لذاته وهو علة المبدأ الثاني وهو المعلول الأول فلزم وجوده من
حيث أنه يعقل ذاته وسائر الأشياء تكون معلولة على نسق الوجود منه وتجرده
لذاته عن المادة أمر سلبي محض فلم تتكثر الذات بسلب شيء منه كما يقال
الإنسان ليس بحجر ولا مدر ولا نجم ولا شجر وكذا إلى غير نهاية فهذا السلب
وإن بلغ إلى غير النهاية لا يوجب تكثيراً في ذاته وإنما قلنا أن تعقله
لذاته أمر سلبي أن العقل هو المجرد عن المادة وتجريده عن المادة سلب
المادة عنه فلزم أن يكون عالماً لتجرده عن المادة وعلائقها إذ المادة هي
التي كانت حجاباً عن التعقلات فلما ارتفع الحجاب صار العقل مدركاً عند
ارتفاع الحجاب المحسوس أدراك الحس المحسوس وعند ارتفاع الحجاب المعقول
إدراك العقل المعقول وليس يختص ذلك بتعقل الباري تعالى بل كل عقل ونفسي
إذا تجرد عن المادة عقل وأدرك بمقدار تجرده ثم ذات العقل الأول لا يحتجب
عن ذاته أبداً فهو عاقل بنفسه أبداً وكل عقل ونفس مفارق للمادة فحكمه كذلك
إلا أن من المواد ما يكون في ألطف ما يكون كالأجسام السماوية فكان حجابها
لعقولها ونفوسها أقل تأثيراً إلى أن يصل في الدرجة العليا إلى ما لا يخالط
مادة البتة فيكون أكمل الأشياء تعقلاً وإدراكاً ومن المواد ما يكون في
أكثف ما يكون كالأجسام الأرضية فكان حجابها لإدراكاتها أكثر تأثيراً إلى
أن ينزل في الدرجة السفلى إلى ما لا يفارق مادة البتة فيكون أكثر الأشياء
خموداً وجموداً والعقل الأول وإن فارق المادة من كل وجه إلا أن ذاته
باعتبار ذاته ممكن الوجود فلم يخرج عن الإمكان وطبيعة الإمكان عدمية مادية
لم يصل تعقله إلى درجة العلة الأولى إذ هو أجل الأشياء إدراكاً لا أجل
الأشياء كمالاً إذ هو برئ عن طبيعة الإمكان والعدم.
قالت الصفاتية
الباري تعالى يعلم ذاته ويعلم ما يلزم منه بعلمين أم بعلم واحد فإن قلتم
المعلومان يستدعيان علمين فقد ناقضتم مذهبكم وزريتم علينا وإن قلتم بعلم
واحد فيعلم الذات من حيث يعلم اللازم ويعلم اللازم من حيث يعلم الذات فيجب
أن تكون الذات لازماً واللازم ذاتاً لأنه إنما يلزم منه ما يلزم لعلمه
بذاته وهو من حيث ذاته يعلم اللازم فيوجد منه الذات كما يوجد منه اللازم
أو كان لا يوجد منه اللازم كما لا يوجد منه الذات وإن كان يعلم الذات لا
من حيث يعلم اللازم فقد تعدد الاعتبارات فتكثر الذات بتكثر الوجوه
والاعتبارات على ما سنفرد مسئلةً في العلم الأزلي خاصة وتحقيق تعلقه
بالمعلومات لكن الذي يختص بمسئلتنا هذه إلزام الوجوه والاعتبارات في
الصفات التي أثبتموها وقولكم تجرده عن المادة أمر سلبي أي هو مفارق ليس في
مادة أصلاً لا لشيء جرده عن المادة بل لذاته وبذاته ولا يوجب تكثراً في
الذات.
قلنا من المعلوم أن قولنا عالم يشعر بتبين المعلوم وقولنا
ليس في مادة يشعر بنفي المادة عنه والمفهومان متغايران لفظاً ومعنىً فكيف
يقال أحدهما هو الثاني بعينه لعمري يصح أن يقال أحدهما سبب لوجود الثاني
على معنى أن المادة إذا ارتفعت ارتفع الحجاب فأدرك الشيء وعقله كالمرآة
المصدية إذا صقلت وارتفع الصدأ تمثلت صورة المحسوس فيها كذلك إذا ارتفعت
المادة يتبين الشيء المعقول في الذهن والعقل وإذا تبين المعقول ارتفعت
الحجب كلها وكلا الوجهين صحيح إما أن يكون أحدهما عين الثاني حتى يكون
إطلاق بالترادف فذلك خطأ ظاهر وما ذكرتموه من تفريع مذهبكم على هذه
القاعدة نتكلم عليها بعد هذه المسئلة إن شاء الله تعالى ونقول إذا كان
الوجود من حيث هو وجود يعم الواجب والممكن فالذات القائم بالنفس من حيث
أنه ذات قائم بالنفس يعم الواجب والممكن فما الذي يخص الواجب من أمر وراء
ذاته حتى يتميز عن سائر الذوات فإن لم يكن له ما يخصه فليس له ما يعمه وإن
كان التخصيص وقع بالذات فهلا قلتم وقع التخصيص بالوجود دون الوجوب وإن وقع
التخصيص بأمر دون أمر فذلك الأمر الذي خصص وعين هو الصفة عندنا إلا أنا
بحكم الشرع أطلقنا اسم العلم والقدرة والإرادة على ذلك وأنتم ما خالفتمونا
في العلم والقدرة بل قلتم هو تعالى عالم لذاته وذاته علم وإن كان الذات من
حيث هو ذات شاملاً شمول الوجود والتخصيص إنما يقع بأمر وصفة وبالجملة كل
أمر عام وجودي إذا تخصص فإنما يتخصص بأمر خاص وجودي فيلزم هناك أثنينية من
المعنى عام وخاص وسواء كان العام جنساً والخاص فصلاً وسواء لم يكن الأمر
كذلك.
فإن قيل قد يتخصص الشيء بالفصول السلبية والسلب لا يوجب الاثنينية.
قيل هذا خطأ وقع للمنطقيين منكم حيث ظنوا أن السلب يجوز أن يكون فصلاً
ذاتياً.
والبرهان
على استحالة ذلك أن الفصل لا يتحقق ما لم يتحقق في المفصول اشتراك ما في
أعم وصف فيكون الفصل أعني ما به تميز عن غيره من المشتركات أخص وصف الشيء
والشيء إنما يتميز عن غيره بأخص وصفه وسلب صفة وشيء آخر عنه وبما يطلقه
على أخص وصفه لا أن يكون نفسه أخص وصفه.
فلما ضاق على بعض الفلاسفة
التعبير عن الفصول الذاتية بعبارات ناصة عليها أوردوا فصولاً سلبية على أن
تطلع الطالب على نفس المطلوب ظن بعضهم أن السلوب تصلح أن تكون فصولاً
ذاتية وذلك خطأ بين ثم ارتكبوا على مقتضى ذلك أن جعلوا وجوب الوجود أمراً
سلبياً وفصلوا به ذات واجب الوجود عن سائر الذوات ولم يفطنوا لإمكان
الوجود الذي في مقابلة وجوب الوجود أنه يلزم أن يكون فصلاً إيجابياً ويا
ليت شعري كيف يتأكد الوجوب بالسلب وكيف يضعف الوجود بالإيجاب وكيف يكون
سلب الغير تأكيداً لذات الوجود الواجب وإيجاب الذات لا يكون تأكيداً
وبالجملة كلما يتميز عن غيره فإنما يتميز بأخص وصفه وأخص وصف الشيء
الموجود لا يكون إلا أمراً وجودياً.
فإن قيل هذا خبر ما عندنا في الوجود وعمومه وخصوصه وقد لزم عليه ما لزم
فما خبر ما عندكم حتى لا يلزم المحال الذي لزم.
قلنا
وجه الخلاص من هذه الإلزامات المفحمة والتقسيمات الملزمة للتكثر أن نجعل
الوجود من الأسماء المشتركة المحضة التي لا عموم لها من حيث معناها وإنما
اللفظ المجرد يشملها كلفظ العين فيطلق الوجود على الباري تعالى لا بالمعنى
الذي يطلق على سائر الموجودات وذلك كالوحدة والقدم والقيام بالذات وليس ثم
خصوص وعموم ولا اشتراك ولا افتراق كذلك في كل صفة من صفاته يقع هذا
الاشتراك لكن إذا سلكتم أنتم هذه الطريقة أفسد عليكم باب التقسيم الأول
للوجود وبطل قول أستاذكم في أنا لا نشك في أصل الوجود وأنه ينقسم إلى واجب
لذاته واجب لغيره فإن المشتركات في اللفظ المجرد لا تقبل التقسيم المعنوي
ولذلك لم يجز أن يقال أن عيناً وأنها تنقسم إلى الحاسة الباصرة وإلى الشمس
وإلى منبع الماء إذ هي مختلفة بالحقائق والمعاني والله المستجار سبحانه ما
يكون لنا أن نقول فيه بغير حق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
القاعدة العاشرة
في العلم الأزلي خاصة
وأنه
أزلي واحد متعلق بجميع المعلومات على التفصيل كلياتها وجزئياتها وذهب جهم
بن صفوان وهشام بن الحكم إلى إثبات علوم حادثة للرب تعالى بعدد المعلومات
التي تجددت وكلها لا في محل بعد الاتفاق على أنه عالم لم يزل بما سيكون
والعلم بما سيكون غير والعلم بالكائن غير.
وذهبت قدماء الفلاسفة إلى
أنه عالم بذاته فقط ثم من ضرورة علمه بذاته يلزم منه الموجودات وهي غير
معلومة عنده أي لا صورة لها عنده على التفصيل والإجمال.
وذهب قوم منهم
إلى أنه يعلم الكليات دون الجزئيات وذهب قوم إلى أنه يعلم الكلي والجزئي
جميعاً على وجه لا يتطرق إلى علمه تعالى نقص وقصور.
أما الرد على
الجهمية هو أنا نقول لو أحدث الباري لنفسه علماً فإما أن يحدثه في ذاته أو
في محل أو لا في ذاته ولا في محل والحدوث في ذاته يوجب التغيير والحدوث في
محل يوجب وصف المحل به والحدوث لا في محل يوجب نفي الاختصاص بالباري تعالى
وبمثل هذا نرد على المعتزلة في إثبات إرادات لا في محل.
وبرهان آخر
نقول لو قدر معنى من المعاني لا في محل كان قائماً بذاته غير محتاج إلى
محل يقوم به ففي احتياج العلم إلى محل إما أن يكون معنى يرجع إلى ذات كونه
علماً فيجب أن يكون كل علم غير محتاج إلى محل وإما أن يكون لأمر زائد على
ذات كونه علماً فيجب أن يكون فعلاً لفاعل فوجب أن يكون فعل الفاعل يوجب
نفي الاحتياج في كل عرض وكل معنى وليس الأمر كذلك ثم فعل الفاعل لا يوجب
أن ينتسب إليه المفعول بأخص وصفه الذاتي بل إنما ينتسب إليه من حيث كونه
فعلاً فقط حتى يسمى فاعلاً صانعاً إما أن يصاف إليه حكم العلمية حتى يصير
عالماً فمحال وأيضاً فإن فعل الفاعل لا يخرج الشيء عن حقيقته فلا يجوز أن
يقلب الجوهر عرضاً والعرض جوهراً فإن القدرة إنما تتعلق بما يمكن وجوده
وهذا من المستحيل فنفي الاحتياج إلى محل في حق الجوهر لا يجوز أن يثبت
بالقدرة كما أن إثبات الاحتياج إلى المحل في حق العرض لا يجوز أن يثبت
بالقدرة وما ليس يمكن لا يكون مقدوراً وما ليس بمقدور يستحيل أن يوجد.
قال
هشام فقد قام الدليل على أن الباري سبحانه وتعالى عالم في الأزل بما سيكون
من العالم فإذا وجد العالم هل بقي علمه علماً بما سيكون أم لا فإن لم يكن
علماً بما سيكون فإذا قد تجدد له حكم أو علم فلا يخلو أن يحدث ذلك المتجدد
في ذاته كما سبق من استحالة كونه محلاً للحوادث ولا يجوز أن يحدثه في محل
لأن المعنى إذا قام بمحل رجع حكمه إليه فبقي أنه يحدثه لا في محل وإن كان
علمه بما سيكون باقياً على تعلقه الأول فكان جهلاً ولم يكن علماً وأيضاً
فإنه قد تجدد له حكم بالاتفاق وهو كونه عالماً بوجود العالم وحصوله في
الوقت الذي حصل وتجدد الحكم يستدعي تجدد الصفة كما أن تحقق الحكم يستدعي
تحقق الصفة ألستم تلقيتم كونه ذا علم من كونه عالماً فلذلك نتلقى تجدد
العلم من تجدد كونه عالماً حتى لو قيل كان عالماً في الأزل بكون العالم
كان محالاً وكان العلم جهلاً بل لو لم يكن العالم معلوم الكون في الأزل
فصار معلوم الكون في الوقت الذي حصل فلم يكن الباري عالماً بالكون في
الأزل ثم صار عالم الكون في الوقت المحصل فدل ذلك على تجدد العلم.
قال
ولا نشك بأن علمنا بأن سيقدم زيد غداً ليس علماً بقدومه بل العلم بأن
سيقدم غير والعلم بقدومه غير ويجد الإنسان تفرقة ضرورية بين حالتي علميه
وهذه التفرقة راجعة إلى تجدد علم في حال القدوم ولم تكن قبل ذلك.
وأما
قولكم أن العلم من جملة المعاني وهي لذواتها محتاجة إلى محل وأنها في
ذواتها مختصة بمن له أحكامها فصحيح إلا أنا بضرورة التقسيم التزمنا كونه
لا في محل إذ لا محل لنفي التفرقة بين الحالتين ولا وجه لتجدد المعنى في
الأزلي القديم ولا في الجسم الحادث فبالضرورة قلنا هو معنى لا في محل له
ولا ينحا به نحو الجوهر من كل وجه حتى يقال هو قائم بالنفس ومتحيز أو قابل
للعرض وإنما يختص حكمه بالفاعل لأن الفاعل هو الذي أوجده علماً لنفسه فصار
علماً به ولأن الباري تعالى لا في محل والعلم لا في محل فاختصاص ما لا محل
له بما لا محل له أولى من اختصاص بما له مكان ومحل.
وللمتكلمين في
جواب شبهة هشام وجهم طرق وللفلاسفة طرق أيضاً قال الشيخ أبو الحسن الأشعري
رضي الله عنه على طريقته لا يتجدد لله تعالى حكم ولا يتعاقب عليه حال ولا
تتجدد له صفة بل هو تعالى متصف بعلم واحد قديم متعلق بما لم يزل ولا يزال
وهو محيط بجميع المعلومات على تفاصيلها من غير تجدد وجه العلم أو تجدد
تعلق أو تجدد حال له لقدمه والقدم لا يتغير ولا يتجدد له حال وإضافة العلم
الأزلي إلى الكائنات فيما لا يزال كإضافة الوجود الأزلي إلى الكائنات
الحاصلة في الأوقات المختلفة وكما لا تغير ذاته بتغير الأزمنة لا يتغير
علمه بتجدد المعلومات فإن العلم من حقيقته أن يتبع المعلوم على ما هو به
من غير أن يكتسب منه صفة ولا يكسبه صفة والمعلومات وإن اختلفت وتعددت فقد
تشاركت في كونها معلومة ولم يكن اختلافها لتعلق العلم بها بل اختلافها
لأنفسها وكونها معلومة ليس إلا تعلق العلم بها وذلك لا يختلف وكذلك تعلقات
جميع الصفات الأزلية فلا نقول يتجدد عليها حال بتجدد حال المتعلق فلا نقول
الله تعالى يعلم العدم والوجود معاً في وقت واحد فإن ذلك محال بل يعلم
العدم في وقت العدم ويعلم الوجود في وقت الوجود والعلم بأن سيكون هو بعينه
علم بالكون في وقت الكون إلا أن من ضرورة العلم بالوجود في وقت الوجود
العلم بالعدم قبل الوجود ويعبر عنه بأنه علم بأن سيكون.
والذي يوضح
الحق في ذلك هو أنا لو علمنا قدوم زيد غداً بخبر صادق أو غيره وقدرنا بقاء
هذا العلم على مذهب من يعتقد جواز البقاء عليه ثم قدم زيد ولم يحدث له علم
بقدومه لم يفتقر إلى علم آخر بقدومه إذا سبق له العلم بقدومه في الوقت
المعين وقد حصل ما علم وعلم ما حصل إذ لو قدرنا أنه لم يتجدد له علم ولم
تتجدد له غفلة وجهل استحال أن يقال لم يعلم قدومه بل يجب أن يقال تنجز ما
كان متوقعاً وتحقق ما كان مقدراً وحصل ما كان معلوماً.
وقولهم إن
الإنسان يجد تفرقةً بين حالتيه قبل قدومه وحال قدومه فتلك التفرقة ترجع
إلى تجدد العلم فليس ذلك على الإطلاق بل يرجع في حق المخلوقين إلى إحساس
وإدراك لم يكن فكان وفي حق الخالق لا تفرقة بين المقدر والمحقق والمنجز
والمتوقع بل المعلومات بالنسبة إلى علمه تعالى على وتيرة واحدة وقال هذا
العلم المتجدد يحصل عندكم قبل الوجود المتجدد بلحظة فإذا تقدمه بلحظة كان
أيضاً علماً بما سيكون لا علماً بالكائن فهو والعلم الأزلي بما سيكون سواء
وإذا جاز تقدمه جاز قدمه.
ثم ألزم عليهم إلزام لا محيص لهم عنه وهو أن
هذه العلوم المتجددة هل هي معلومة قبل كونها موجودة أم ليس يتعلق العلم
بها فإن كانت معلومة أفبعلم الأزلي وعالميته أم بعلوم أخر سبقتها قبل
وجودها فإن كان الأول فجوابنا عن الكائنات في كونها معلومة بعلم الأزل
جوابكم عن العلوم المتجددة وإن كان الثاني فكانت محتاجة إلى علوم أخر
والكلام في تلك العلوم كالكلام في هذه ويؤدي إلى التسلسل وقد ألزم أصحاب
الإرادات الحادثة لا في محل هذا الإلزام واعتذروا بأن قالوا الإرادة لا
تراد وهذا العذر لا يصح على قاعدة هشام وجهم فإن الإرادة وإن كانت لا تراد
فهي بخلاف العلم لأن العلم يعلم فيلزم القول بالتسلسل وهذا الإلزام قد
أفحم الكرامية في مسئلة محل الحوادث.
وقالت المعتزلة على طريقتهم
الباري تعالى عالم لذاته أزلاً بما سيكون ونسبة ذاته أو وجه عالميته إلى
المعلوم الذي سيكون كنسبته إلى المعلوم الكائن الموجود والعالم منا بما
سيكون عالم على تقدير الوجود وبما هو كائن عالم على تحقيق الوجود
فالمعلومات بعلم واحد جائز تقديراً أو تحقيقاً وعندهم يجوز تقدير بقاء
العلم ويجوز تعلق العلم الواحد بمعلومين ولا استحالة فيه شاهداً وغائباً
ثم إن بعضهم يقول يرجع الاختلاف في الحالتين إلى التعلق لا إلى المتعلق
بخلاف ما قال الأشعري أن الاختلاف يرجع إلى المتعلِق لا المتعلَق والتعلق
وقال بعضهم يرجع الاختلاف في الحالتين إلى حالتين.
وقد مال أبو الحسين
البصري إلى مذهب هشام بعض الميل حتى قضى بتجدد أحوال الباري تعالى عند
تجدد الكائنات مع أنه من نفاة الأحوال غير أنه جعل وجوه التعلقات أحوالاً
إضافية للذات العالمية وهو في جميع مقالاته ينهج مناهج الفلاسفة ويرد على
شيوخه من المعتزلة بتصفح أدلتهم رداً شنيعاً.
وقالت الفلاسفة على
طريقهم واجب الوجود ليس يجوز أن يعقل الأشياء من الأشياء وإلا فذاته إما
متقومة بما يعقل أو عارض لها أن يعقل وذلك محال بل كما أنه مبدأ كل موجود
فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له وهو مبدأ للموجودات التامة بأعيانها
والموجودات الكائنة الفاسدة بأنواعها وأشخاصها ولا يجوز أن يكون عاقلاً
لهذه التغيرات مع تغيرها حتى يكون تارة يعقل منها أنها موجودة غير معدومة
وتارة يعلمها معدومة غير موجودة ولكل واحد من الأمرين صورة عقلية على حدة
ولا واحد من الصورتين يبقى مع الثانية فيكون واجب الوجود متغير الذات بل
هو إنما يعقل كل شيء على نحو كلي فعلي لا انفعالي ومع ذلك لا يعزب عنه شيء
شخصي ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وأما كيفية ذلك
فلأنه إذا عقل ذاته وعقل أنها مبدأ كل موجود عقل أوائل الموجودات وما
يتولد منها ولا شيء من الأشياء يوجد إلا وقد صار معلوماً من جهة ما يكون
واجباً بسببه فتكون الأسباب بمصادمات تتأدى إلى أن يوجد منها الأمور
الجزئية فالأول يعلم الأسباب ومطابقاتها فيعلم ما يتأدى إليه وما بينها من
الأزمنة وما لها من العودات فيكون مدركاً للأمور الجزئية من حيث هي كلية
أعني من حيث لها صفات وأحوال تستعد بها لأن تكون كلية وإن تخصصت فبالإضافة
إلى زمان ومكان وحال متشخصة فيعقل ذاته ونظام الخير والموجود في الكل منه
ونفس مدركة الكل سبب لوجود الكل منه ومبدأ له وإبداع وإيجاب وإيجاد فلا
يتبع علمه معلوماً بل يسبقه ولا يكتسب عنه صفة بل يكسبه ولا يتغير بتغير
المعلوم بل يغيره ولا يتعلق بأمر معين من حيث هو معين شخصي حتى لو زال
الشخص زال العلم بوجوده وهذا كمن عرف أن القمر إذا اجتمع مع الذنب في برج
كذا وكانت الشمس في برج مقابل وقع ثم الكسوف فعلمه هذا قبل وجود الكسوف
وبعده وفي حال الكسوف على وجه ليس يتغير بحدوث الكسوف وكذا كل علم كلي ثم
الجزئي مندرج تحت الكلي على سبيل التضمن فيصير الكل معلوماً له على هذا
الطريق فمن قال منهم أنه لا يعقل إلا ذاته أراد به أنه يعقل كونه مبدأ
وعقله ذلك هو الموجب لحصول ما يصدر عنه ومن قال منهم أنه يعقل الكليات دون
الجزئيات أراد ما قررناه ومن قال منهم أنه يعقل الكليات والجزئيات أراد ما
عقله مقصوداً أي مبدأ وما يصدر عنه إلا أن ذلك على وجه فهذا كلام القوم
ونحن نتكلم على ذلك بالاعتراض وبتصفح على كل مسئلة منها بالاستعراض.
فنقول
أولاً إطلاق لفظ العقل والعاقل غير مصطلح عليه عندنا فنغير لفظ العقل إلى
العلم ونطلق لفظ العالم بدل العاقل إذ ورد السمع بكون الباري تعالى عالماً
ولم يرد بكونه عاقلاً فنطالبكم بالدليل على كون الباري تعالى عالماً فبما
عرفتم ذلك والدليل ما أرشدكم إليه والبرهان لم يقم عليه فإن المتكلم يستدل
بحصول الإحكام والإتقان في الأفعال على كون الصانع عالماً وأنتم ما سلكتم
هذه الطريقة ولا استقام ذلك على قاعدتكم فإن العلم عندكم لم يتعلق
بالجزئيات أو تعلق على وجه كلي فهو إذاً متعلق بالكليات والأحكام إنما
يثبت في الجزئيات المحسوسة أما الكليات المعقولة فهي مقدرة في الذهن فما
فيه الإحكام ليس بمعلوم على الوجه الذي يقتضيه الإحكام وما هو معلوم فلم
يشاهد إحكام فيه فبطل الاستدلال من هذا الطريق.
قالوا طريقنا في ذلك
إنما هو برئ من المادة وعلائقها فغير محتجب عن ذاته لأن الحجاب هو المادة
والمقدس عن المادة هو عالم لنفسه بنفسه إذ لا حجاب.
قيل هذه مصادرة على
المطلوب الأول فإن معنى قولكم غير محتجب عن ذاته أي هو عالم بذاته والكلام
فيه كالكلام في الأول وتقريره إنما هو برئ من المادة فهو عالم فلم قلتم
إنما هو برئ عن المادة عالم ونفي المادة كيف يناسب العالمية والعلم هذا
كمن نفى التناهي والانقسام والأين والكيف عنه لم يجب من ذلك أن يكون
عالماً فنفى الجسمية والهيولانية عنه ليس يقتضي أن يكون عالماً ولم نجد
لعامتكم برهاناً على ثبوت كونه عالماً بالمعلومات سواء التجرد عن المادة
وعلائقها وليس ذلك حداً أوسط في برهان أن ولا في برهان لم.
قال أبو
علي بن سينا البرهان على أن كل مجرد عن المادة فهو عقل بذاته هو بدليل أن
كل ماهية مجردة عن المادة فلا مانع لها من حيث ذاتها عن مقارنة ماهية أخرى
مجردة فيمكن أن تكون معقولة أي مرتسمة في ماهية أخرى مجردة وارتسامها هو
مقارنتها ولا معنى للعقل إلا أنه مقارنة ماهية مجردة لماهية مجردة ولذلك
إذا ارتسمت في القوة العاقلة منا ماهية مجردة كان نفس الارتسام فيها هو
نفس شعورها بها وإدراكها لها وذلك هو العقل والتعقل إذ لو كان يحتاج إلى
هيئة وصورة غير الصورة المرتسمة لكان الكلام في تلك الصورة كالكلام في هذه
الصورة ويتسلسل وإذا كان نفس تلك المقارنة هو العقل فيلزم منه أن كل ماهية
مجردة فلا مانع لها من ذاتها أن تعقل.
قلت ما زدت في البيان إلا أنك
جعلت المقارنة حداً أوسط ولسنا نشك أنك ما عنيت بهذه المقارنة مقارنة
الجسم ولا مقارنة الجوهر العرض ولا مقارنة الصورة المادة بل عنيت به كما
فسرت التمثيل والارتسام وعنيت بالتمثيل والارتسام التعقل فقد صادرت على
المطلوب الأول أقبح المصادرة فكأنك قلت الدليل على كونه عالماً أنه لا
يمتنع على آنيته وذاته أن يكون مرتسماً بصورة أي عالماً فبان أنك أدرجت
لفظ المقارنة حتى أخفيت الحال ثم فسرت المقارنة حتى أبديت الحال زالت
المصادرة عنك كل الزوال.
وأما استشهادك بالقوة العاقلة منا فإنما ينفعك
مع من لا ينازعك في أن العقل هل يعقل بذاته ذاته وإن عقل أفبعقل غير ذاته
أم بعقل هو ذاته أما من نازعك في إثبات كونه عقلاً وعاقلاً أي علماً
وعالماً فلا ينفعه هذا الاستشهاد.
وأما اقتباس كونه عاقلاً من كونه
معقولاً فهو من أمحل المطلوبات وهو كمن قال لا يمتنع عليه أن يعلم فلا
يمتنع عليه أن يعلم والعرض في ذاته ممتنع أن يعقل ويعلم عند القوم فكيف
يصح القياس وهب أنه يعلم فلم ينبغي أن يعلم ثم أخذ ما يحب مما لا يمتنع من
أبعد القياسات وأمحل المحالات فإن سلمنا لكم كونه تعالى عالماً بذاته
وعلمه بذاته نفس علمه بعلمه فلم قلتم أن علمه بذاته الذي هو نفس العلم
فعلمه بمعلوماته هو علمه بذاته ما هو مبدأ وهو مبدأ كل موجود أفيتعلق علمه
بذاته ثم يتعلق نفس ذلك العلم بمعلوماته على النسق الذي حصل أم يتعلق علمه
بذاته ويتعلق علم آخر بمعلوماته ويلزم على الأول أن يقال لا يعلم إلا ذاته
إذ لا صورة عنده غير ذاته ولا ارتسام لعقله إلا تعقله فإن العقل عندكم
مقارنة ماهية لماهية والمقارنة هو ارتسام ماهية بماهية فعلى هذا التفسير
لم يقترن بوجوده غير وجوده ولا ارتسم في عقليته غير عقليته وسائر اللوازم
كما هي مفارقة لذاته يجب أن يكون معقوليتها مفارقة لمعقولية ذاته ويلزم
على القسم الثاني التكثر الصريح فإن عقله لذاته وعقله للعقل الأول إن كانا
شيئاً واحداً من وجه واحد فيلزم أن تكون ذاته هو العقل الأول والعقل الأول
ذاته وإن لم يكن ذلك على وجه واحد فقد تعدد وتكثر وجوه الذات.
ثم نقول
إذا كان عقله وعلمه علماً فعلياً لا انفعالياً وإنما يلزم منه ما يلزم
لعلمه بذاته فيجب أن يكون كل معلوم مفعولاً له وهو معلوم لعلمه فانظروا أي
شيء يلزم من ذلك.
قال ابن سينا أنه تعالى عالم بالأشياء لا من الأشياء بل الأشياء منه ومن
علمه.
قيل
له فإذاً بطل تقريرك الثاني أن العقل لا معنى له إلا الارتسام ماهية
بماهية فهلا قلت العقل رسم ماهية في ماهية أو هلا قسمت الأمر فقلت من
العقول ما يرتسم ومن العقول ما يرسم ومنها ما لا يرسم ولا يرتسم فعقله
للعقل الأول رسم وليس بارتسام وعقله لذاته ليس برسم ولا ارتسام وعقل العقل
والنفس له ارتسام وليس برسم فعقولنا مثلاً تصورات وعقول المقارنات تصويرات
وتصورات وعقل الباري تعالى لذاته ليس بتصور ولا تصوير وعقله للعقل الأول
تصوير لا تصور.
قال ابن سينا الرب تعالى عالم بالموجودات ولكن علمه بها علم لزومي عن علمه بذاته غير مفصل للصور فإنه يعلم ذاته وإنما يعلم ذاته كما هو عليه وهو أنه مبدأ للموجودات كلها بأسرها فيدخل علمه بالموجودات تحت علمه بذاته من غير أن تترتب للموجودات صورة في ذاته حتى يلزم منه كثرة فإن العلم بلوازم الشيء إذا لم يكن متجهاً نحو تلك اللوازم قصداً بل حاصلاً من العلم بلزومها فلا يكون زائداً على نفس العلم بالملزوم ولا فيه كثرة مترتبة فترتبه حسب ترتيب تلك اللوازم ونحن نجد من أنفسنا مثل هذا العلم بالأشياء الكثيرة من غير أن يتمايز لها صورة في ذاتها وهو أنا إذا سئلنا عن مسئلة نكون قد علمناها وأتقناها لكنا في تلك الحالة معرضون عنها فمع السؤال عنها نجد من أنفسنا التفاتاً إلى جوابها ويقيناً لنا بحصول ذلك العلم المشتمل على جميع الجواب من غير أن يكون في ذلك العلم تفصيل لصور الأشياء التي تنتقش في نفوسنا حين أخذنا في الجواب ثم يأتي التفصيل مع الأخذ في الجواب مرتباً وليس ذلك استعداداً بحتاً ويقيناً بالاستعداد بل يقيناً بحصول العلم لا بالاستعداد وإنما يتيقن المعلوم لا المجهول وأما علم العقل الأول بالباري تعالى فلا يكون لازماً لعلمه بذاته فإن مبدأه قبل ذاته لا لازماً عنه فلا يكون العلم بما هو قبل ذاته لازماً من نفس علمه بذاته فيكون علماً آخر على حدة والمعلوم ليس نفس العالم ولا لازماً منه فيكون زائداً لا محالة على نفس العالم فتحصل فيه كثرة بسبب هذا العلم.
قلت فرقت فرقاً بين علمه بذاته وبين علمه بالأشياء حتى سميت الأول ذاتياً والثاني علماً لزومياً أفتعني بالعلوم اللزومية معلومات له بعلم واحد على طريق اللزوم فذلك صحيح أو تعني بذلك علوماً أخر لزومية لعلمه بذاته فما المتصور بتلك العلوم وما محلها وكيف تتعلق هي بالمعلومات وما معنى أنها غير مفصلة للصور والعلم لا يكون قط إلا مفصلاً فإنه معنى يتعلق بالمعلوم على ما هو به فهو مفصل بالنسبة إلى معلومه وقولك أنه يعلم ذاته كما هو عليه وهو مبدأ للموجودات فيا عجباً من إطلاق الذات والعلم بالذات والمبدأ للموجودات فإن كانت هذه الثلاثة الاعتبارات عبارة عن معبر واحد حتى يقال ذاته علمه وعلمه هو مبدإيته وكونه مبدأ أمر إضافي فكونه ذاتاً وعلماً يجب أن يكون أمراً إضافياً وإن كان ثم اعتبار واعتبار حتى يكون من حيث أنه مبدأ إضافياً ومن حيث أنه علم سلبياً ومن حيث أنه ذات لا سلبياً ولا إضافياً فقد تعددت اعتبارات ثلاثة فذاته ثالث ثلاثة ونقول ما المانع من تعلق العلم الأزلي بالمعلومات على نسق واحد حتى لا يكون منه ما هو بالقصد الأول وهو العلم بالملزوم ولا منه ما هو بالقصد الثاني وهو العلم باللازم إن كان العلم والذات لا يتأثر ولا يتكثر باللوازم والسلوب حتى يقال معنى كونه عالماً أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من غير أن ينسب إليه بعض المعلومات بالذات والبعض بالعرض من غير أن تتغير ذات العالم بالمعلوم كما لم تتكثر ذاته بتكثر اللوازم وأما التمييز في عقولنا إنما هو بحسب إمكان الجهل والغفلة والنسيان وإلا فلو قدرنا علماً لم يطر عليه ضده البتة لم يخف عليه شيء البتة ولعلمنا مباد وكمالات فمبادئها النظر والاستدلال والتفكير والتدبير وكماله أنه لا يخفى علينا المنظور فيه وإنما يطلق العلم على الباري تعالى بحسب الكمال لا بحسب المبدأ كما أن مبدأ أفعالنا المعالجة والمزاولة والاكتساب والمجاهدة وكمالها بأن لا يتعذر علينا شيء وتطلق القدرة على الباري تعالى بحسب الكمال لا بحسب المبدأ وكما أن العفو والعطف منا بحسب المبدأ هو انحصار القلب على حال المعطوف عليه وبحسب الكمال هو الإنعام والملاحظة والإكرام والملاطفة فإذا كان هذا معنى الصفات فلا فرق في تلك النسبة وهو أن لا يخفى عليه شيء من الكلي والجزئي والذاتي والعرضي وإذا فرقتم بين قسم وقسم فقد حكمتم بتعدد الاعتبار وتكثر الجهات والآثار ومن قال أن علم المعلول الأول بالأول ولا يكون لازماً لعلمه بذاته لأن مبدأ المعلول الأول قبل ذاته فلا يكون العلم بما هو قبل ذاته لازماً لعلمه بذاته فيكون علماً آخر على حدة يتوجه على مساق كلامه إن كل من علم شيئاً من حاجته وافتقاره لا يلزمه العلم بالمحتاج إليه لأن المحتاج إليه قبل ذاته وقبل حاجة ذاته بل إنما يعلمه بعلم آخر وليس الأمر كذلك بل العلم ربما يلزم من العلم ولا يستدعي لزوم العلم من العلم أو بالعلم لزوم المعلول من المعلوم وإنما وقع له هذا الغلط من غلط آخر وهو انه اعتقد أن المعلول الأول لزم وجوده من علم العلة الأولى به وعلمه به لزوم من علم العلة الأولى بذاتها فظن أن كل شيء علم وأنه بذاته لزم من علمه بذاته علم بغيره ولزم من علمه بغيره وجوده وهذا محال على أنه أثبت للمعلول الأول علمين علم بذاته وعلم آخر بعلته فيكون قد صدر من العلة الأولى شيء هو جوهر قائم بنفسه قام به معنيان مختلفان محققان ليس يلزم من أحدهما الثاني فقد خالف بذلك أصله الممهد أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ولا يغنيه عذره وأن أحد الشيئين له لذاته والثاني من علته فإن علم المعلول بذاته غير وعلمه بالعلة غير وليس أحد العلمين له لذاته والثاني من علته ثم هو يعلم ذاته ويعلم معلوله الثاني فقد تكثرت الذات بعلوم زائدة على الذات على أنه عقل فعال وإنما عقليته لأنه صورة واهبة للصور فلم تتكثر ذاته بتكثر معلوماته من الصور ولا تتغير بتغير لوازمه من الموجودات فهلا كان الأمر في واجب الوجود كذلك.
وأما من قال منهم
أنه يعلم الأمور على وجه كلي لا يتطرق إليه التغير فنقول كل موجود شخصي في
هذا العالم يستدعي كلياً خاصاً بذلك الشخص فإن كلية الشخص الإنساني وهو
كونه إنساناً ليس بكون كلية شخص حيوان آخر بل الكليات تتكثر بحسب تكثر
الشخصيات فإذا كان لا يعلم الشخصي إلا من نحو كليته حتى لا يتغير العلم
بالكلية ويتغير العلم بالجزية فيلزم أن يتكثر العلم بكليته كما يتكثر
بشخصيته وإن اجتمعت الكليات كلها في كل واحد فيلزم أن لا يكون المعلوم إلا
ذلك الكلي الواحد ثم ذلك الكلي الواحد لازم له في وجوده فيكون العلم به
لازماً للعلم بذاته فهو رجوع إلى محض مذهب من قال أنه لا يعلم إلا ذاته
فما زاد هذا القائل على مذهبه إلا إطلاق لفظ الكلية وهي معلومة لزوماً كما
كانت الجزئيات معلومة لزوماً فلم يستفد من هذه الزيادة شيئاً ومن عرف
مبادئ الموجودات عرف ما يتأدى منها وما يحصل بها نظراً من العلة إلى
المعلول ومن عرف أخص أوصاف الموجودات عرف الأعم نظراً من الملزوم إلى
اللازم وبين البابين بون عظيم بعيد.
وما تمثل به ابن سينا من حديث خسوف
القمر فهو دليل عليه فإن من علم مثل ذلك العلم أعني إذا كان كذا يكون كذا
فيكون علمه مشروطاً وهي قضية شرطية فلا يكون علمه علماً محققاً حتى يقول
إن كان الأمر كذا فهو كذا فصار الأمر جزئاً بعد ما كان كلياً ويتعالى علم
الباري تعالى عن القضايا الشرطية بل عمله أعلى من أن يكون كلياً أو جزئياً
أو متغيراً بتغير الزمان أو متكثراً بتكثر المعلومات انظروا كيف عاد تنزيه
القوم تشبيهاً وكيف صار تحقيق القوم تمويهاً.
قالت الصفاتية إن الإشكال
في هذه المسئلة على جميع المذاهب من جهة أنهم تصوروا تعلق العلم بالمعلوم
على وجه يتطرق إليه الزمان الماضي والمستقبل والحال حتى يقال علم ويعلم
وهو عالم وسيعلم فظنوا أن العلم زماني يتغير بتغير الحوادث ومن تحقق أن
العلم من حيث هو علم لا يستدعي زماناً بل هو في نفسه تبين وانكشاف وذلك
إذا كان صفة للحادث وإحاطة وإدراكاً إذا كان صفة للقديم فهو مع وحدته محيط
بكل الأشياء ومع إحاطته واحد ومن تحقق كونه واحداً سهل عليه الإشكال.
فالبرهان
على أن علمه شيء واحد أنه لو كان كثيراً لم يخل إما أن يتعدد بتعدد
المعلومات كلها والمعلومات من حيث أن لها صلاحية المعلومية من الواجب
والجائز والمستحيل لا تتناهى على التقدير فيلزم أن تكون العلوم المتعلقة
بها لا تتناهى على التحقيق وقد قام الدليل على أن أعداداً في الوجود
المحقق بالفعل لا تتناهى مستحيل وإنما حصره الوجود فهو متناه بالضرورة
وإما أن يتعدد بعدد مخصوص فيستدعي مخصصاً خاصاً والقديم لا مخصص فإذا علمه
تعالى واحد فهو متعلق بجميع المعلومات والمعلومات لا تتناهى فعلمه متعلق
بما لا يتناهى ولا يفرض اختصاصه بمعلوم معين كالعلم الحادث فإن الاختصاص
والانحصار نقص وقصور من حيث أنه لا يختص إلا بمخصص والدليل على ذلك أن ما
من علم يفرض إلا ويصح تعلق علم واحد منا به ثم لا يثبت لنا العلم بالمعلوم
إلا ضرورياً أو كسبياً وعلى أي الوجهين فرض ثبوته فالله تعالى موجده
ومبدعه فإذا وجد كان عالماً به وإذا وجب كونه عالماً بالعلم فهو عالم
بالمعلوم إذ يستحيل أن يعلم العلم ولا يعلم المعلوم فلزم أن يكون العلم
القديم متعلقاً بكل معلوم وإنما اقتصر العلم الحادث على بعض المعلومات
لجواز طريان الضد عليه وإلا فالعلم من حيث هو علم لم يمتنع عليه التعلق
بكل معلوم وكذلك كل صفة قديمة فإن متعلقاتها لا تتناهى فقد أطلقت الأشعرية
بأن معلومات الله تعالى في كل معلوم لا تتناهى وأشاروا بذلك إلى التقديرات
الجائزة في حق كل معلوم إذ ما من وقت من الأوقات وحين من الأحيان إلا
ويجوز وقوع الحادثة فيه على البدل وكذلك ما من عرض إلا ويجوز اختصاصه بكل
جوهر على البدل.
قال المعترض تلقيتم وحدة العلم الأزلي من استحالة
علوم غير متناهية يحصرها الوجود ومن أن الاختصاص بعدد مخصوص ثم ارتكبتم
مثله في العلم الواحد حيث قلتم أنه واحد متعلق بمعلومات لا تتناهى فقد
أثبتم له تعلقات حقيقية أو تقديرية لا تتناهى وما حصره الوجود كيف يشتمل
على تعلقات غير متناهية فإن قلتم أنها على التقدير المفروض لا تتناهى
فالتقدير فكيف يتصور في حق القديم سبحانه وإن قلتم أنها على التحقيق
الموجود فالتحقيق للمتعلق كالتحقيق للمتعلق فلم لا يجوز علوم غير متناهية
ثم التناهي بعدد مخصوص كالتناهي بالواحد فإن أوجب اختصاص العدد مخصصاً
كذلك يستدعي اختصاص الوحدة مخصصاً وهو كما أن كثرة نوع الإنسان في الوجود
استدعى مكثراً ووحدة نوع الشمس في الوجود استدعت موحداً ثم معلومات الله
تعالى مجملة أم مفصلة فإن قلتم أنها مجملة على معنى أنه يعلم ما لا يتناهى
من حيث أنها لا تتناهى من غير أن ينفصل معلوم عن معلوم فهو علم واحد تعلق
بمعلوم واحد وما ينفصل به بقي مجهولاً وإن قلتم أنها مفصلة على معنى أنها
تتميز في علمه بخصائص صفاتها فالجمع بين التفصيل ونفي النهاية مستحيل فما
الجواب عن هذه المشكلات.
قالت الصفاتية لسنا نعني بالتعلقات علائق حسية
ولا حبائل خيالية ولا ينفي التناهي عن المعلومات أعداداً من المعلومات غير
متناهية حاصرة في الوجود بل نعني بالتعلق والمتعلق أن الصفة الأزلية صالحة
لدرك ما يعرض عليها على وجه لا يستحيل فيعبر عن تلك الصلاحية نحو الدرك
بالتعلق ويعبر عن جهة العرض عليه حتى يدركه بالمتعلق ثم وجوه الجائزات على
التقدير غير متناهية فالمتعلقات غير متناهية فالتعلقات غير متناهية فالعلم
القديم صفة متهيئة لدرك ما يعرض عليها على وجه الجواز دون الاستحالة
والقدرة الأزلية صفة متهيئة لإيجاد ما يعرض عليها على وجه الجواز دون
الاستحالة فالمعنى بالعرض جهة الإمكان وتعيين الآحاد على البدل والمعنى
بالمعروض عليه جهة الصلاحية إما نحو الإدراك وإما نحو الإيجاد وهذا كما أن
الصور المتعاقبة على الهيولي عند القوم لا تتناهى على البدل وإنها فائضة
على الهيولي من واهب الصور وذات واهب الصور واحدة إلا أنها على صفة لها
صلاحية الفيض حتى ما يتهيأ الهيولى لقبول الصورة فتعرض الإمكان على القدرة
كتهي الهيولي لقبول الصور وصلاحية الصفة له نحو الإدراك والإيجاد كصلاحية
الواهب لفيض الصورة ثم الواهب واحد ومع وحدته على كمال يفيض منه صور لا
تتناهى على البدل فذات الواهب واحدة ولكنه في حكم ما لا يتناهى والصورة لا
تتناهى ولكنها في حكم الواحد ثم ما حصره الوجود فهو متناه وما قدره المقدر
غير متناه فإن التقدير تعبير عن الصلاحتين أو نبا عن الاستعدادين واستعمال
لفظ الصلاحية في جانب القديم توسع وفي جانب الحادث حقيقة فإن القديم
بالإعطاء أجدر والحادث بالقبول أولى ثم جهات الإمكان لا تتناهى وهي تشترك
كلها في جهة الإمكان المحتاج إلى من يخرجه من وجه الإمكان إلى عين الوجود
فوجوه الممكنات كلها إلى القديم سبحانه وهو تعالى من حيث العلم يحيط بها
ويدركها بوجه واحد وهو صلاحية العلم نحو الإدراك ويوجدها ويخترعها بوجه
وهو صلاحية القدرة نحو الإيجاد وتخصصها بمثل دون مثل بوجه وهو صلاحية
الإرادة نحو التخصيص ويتصرف فيها بتكليف وتعريف بوجه وهو صلاحية الكلام
نحو الأمر والنهي ثم هل تشترك هذه الحقائق والخصائص في صفة واحدة أم في
ذات واحدة فتلك الطامة الكبرى على المتكلمين حتى فر القاضي أبو بكر
الباقلاني رضي الله عنه منها إلى السمع وقد استعاذ بمعاذ والتجاء إلى ملاذ
والله الموفق.
القاعدة الحادية عشر
في الإرادة
وهي تتشعب إلى ثلاث مسائل أحدها في كون الباري تعالى مريداً على الحقيقة الثانية في أن إرادته قديمة لا حادثة والثالثة أن الإرادة الأزلية متعلقة بجميع الكائنات.أما الأولى فالكلام فيها مع النظام والكعبي والجاحظ والنجار فذهب النظام والكعبي إلى أن الباري تعالى غير موصوف بها على الحقيقة وإن ورد الشرع بذلك فالمراد بكونه تعالى مريداً لأفعاله أنه خالقها ومنشئها وإن وصف بكونه مريداً لأفعال العباد فالمراد بذلك أنه أمر بها وإن وصف بكونه مريداً في الأزل فالمراد بذلك أنه عالم فقط.
وذهب النجار إلى أن معنى كونه مريداً أنه غير مغلوب ولا مستكره.
وذهب
الجاحظ إلى إنكار أصل الإرادة شاهداً وغائباً وقال مهما انتفى السهو عن
الفاعل وكان عالماً بما يفعله فهو مريد وإذا مالت نفسه إلى فعل الغير سمي
ذلك الميلان إرادة وإلا فليست هي جنساً من الأعراض وهو الأولى بالابتداء
وهو الأهم بالرد عليه.
فيقال له إثبات المعاني والأعراض ثم التمييز بين
حقيقة كل واحد منها إنما يبتني على إحساس الإنسان من نفسه وكما يحس
الإنسان من نفسه علمه بالشيء وقدرته عليه يحس من نفسه قصده إليه وعزمه
عليه ثم قد يفعله على موجب إرادته وقد لا يفعله على موجب إرادته وربما
يريد فعل الغير من غير ميل النفس والتوقان إليه وكذلك يريد فعل نفسه من
غير ميل وشهوة كمن يريد شرب الدواء على كراهية من نفسه وبالجملة الإحساس
حاصل ورده إلى العلم بالفعل باطل فإن العلم تبين وإحاطة فقط وهو يطابق
المعلوم على ما به من غير تأثير في المعلوم ولا تأثير منه وكذلك يتعلق
بالقديم والحادث والقصد والإرادة يقتضي ويخصص فيؤثر ويتأثر ولذلك لا يتعلق
إلا بالمتجدد والحادث فبطل مذهب الجاحظ.
وأما الرد على الكعبي والنظام
بعد اعترافهما بكون الإرادة جنساً من الأعراض في الشاهد أن نقول قام
الدليل على أن الاختصاص ببعض الجائزات دون البعض في أفعال العباد دليل على
الإرادة والقصد والدليل يطرد شاهداً وغائباً فإن الأحكام والإتقان لما دل
على علم الفاعل شاهداً دل عليه غائباً والدليل العقلي لا ينتقض ولا يقتصر.
قال
الكعبي إنما دل على الاختصاص على الإرادة في الشاهد لأن الفاعل لا يحيط
علماً بكل الوجوه في الفعل ولا بالمغيب عنه ولا بالوقت والمقدار فاحتاج
إلى قصد وعزم إلى تخصيص وقت دون وقت ومقدار دون مقدار والباري تعالى عالم
بالغيوب مطلع على سرائرها وأحكامها فكان علمه بها مع القدرة عليها كافياً
عن الإرادة والقصد إلى التخصيص وأنه لما علم أنه يختص كل حادث بوقت وشكل
وقدرة فلا يكون إلا ما علم فأي حاجة به إلى القصد والإرادة وأيضاً فإن
الإرادة لو تحققت فإما أن تكون سابقة على الفعل أو حادثة مع الفعل فإن
كانت سابقة فهي عزيمة والعزم لا يتصور إلا في حق من يتردد في شيء ثم أزمع
عليه أو انتهى عن شيء ثم أقبل إليه وإن كانت مقارنة فهي إما أن تحدث في
ذاته أو في محل أولا في ذاته ولا في محل والأقسام الثلاثة باطلة بما سبق
بطلانها فتعين أن الإرادة للقديم سبحانه لا معنى لها إلا كونه عالماً
قادراً فاعلاً.
قيل له قد سلمت في الأفعال وجوهاً من الجواز في تخصيصها
ببعض الجائزات دون البعض فينظر بعد ذلك أهو من دلائل العلم أو من دلائل
الإرادة.
فنقول قد بينا بأن العلم يتبع المعلوم على ما هو به سواء كان
العلم محيطاً بجميع الوجوه في الفعل وقتاً ومقداراً وشكلاً أو لم يكن
فالعلم من حيث هو علم لا يختلف وإن قدر اختلاف في العلم حتى يكون أحد
العلمين مخصصاً دون الثاني فلنقدر مثل ذلك فيه حتى يكون أحدهما موجداً
والثاني غير موجد ويقع الاجتزاء بالعلم عن القدرة كما وقع به عن الإرادة
فيعود الكلام إلى مذهب الفلاسفة أن علمه تعالى علم فعلي فيوجد من حيث يعلم
ويختار الأفضل من حيث يعلم وإن وجب أن تعطى كل صفة حظها من الحقيقة فالعلم
ما يحصل به الإحكام والإتقان والإرادة ما يحصل بها التخصيص والقدرة ما
يحصل بها الإيجاد والقضايا مختلفة فالمقتضيات إذاً غير متحدة.
وأما
قوله إثبات الإرادة في الشاهد لامتناع الإحاطة بالمراد من كل وجه فباطل
لأنا لو فرضنا الإحاطة بالفعل من كل وجه بإخبار صادق أو غيره من الطرق كان
يجب أن يستغنى عن الإرادة وليس الأمر كذلك وتقسيمه القول بأن الإرادة إما
سابقة وإما مقارنة.
قيل له قد عرفت على هذا مذهب الصفاتية أن
الإرادة أزلية فهي سابقة على المراد ذاتاً ووجوداً ومقارنة الحال التجدد
تعلقاً وتخصيصاً والعلم يتبع الواقع ولا يوقع والقدرة توقع المقدور ولا
تخصص والإرادة تخصص الواقع على حسب ما علم بما علم والصفة أزلية سابقة
والمراد حادث متأخر وليس يلزم على ذلك أن يسمى عزماً فإن العزم توطين
النفس بعد تردد ولو كان المريد للشيء متمنياً أو مشتهياً أو مائلاً لوجب
أن يقال العالم بالشي معتقد ساكن النفس مترو ومتفكر فبطل الاستدلال من هذا
الوجه وليس كل من علم شيئاً إرادة ولا كل من أراد شيئاً قدر عليه بل كل من
فعل شيئاً فقد قدر عليه ومن قدر على فعل شيء إرادة ومن أراده علمه
فالإرادة تتبع العلم حتى يتصور أن يكون عالماً ولا يكون مريداً ولا يتصور
أن يكون مريداً ولا يكون عالماً.
أما الرد على النجار حيث قال أنه مريد
بمعنى أنه غير مغلوب ولا مستكره فيقال له فسرت حكماً ثابتاً بنفي كمن يفسر
كونه قادراً بأنه غير عاجز وكونه عالماً بأنه غير جاهل وذلك مذهب المعطلة
الفلاسفة ثم تجرد نفي العجز والكراهية لا يقتضي كون الذات مريداً فإن
كثيراً من الأجسام ينفي عنها العجز والكراهية ولا يكون مريداً وكثير من
المريدين كاره كمن شرب الدواء على كراهية من طبعه وهو مريد له فالكراهية
تضاد الطوع وأما القصد فقد يجامع الكراهية.
ثم نقول كونه غير مغلوب ولا
مستكره أمر مجمع عليه وإنما الكلام في أنا رأينا في الأفعال ما يدل على
كون الصانع مريداً وهو اختصاص الأفعال ببعض الجائزات دون البعض وإهمال هذه
القضية غير ممكن فما مدلول هذا الدليل فإن قلتم مدلوله أنه غير مغلوب ولا
مستكره.
فيقال إنما استفدنا العلم بذلك من كونه قادراً على الكمال
والاختصاص لم يدل على القدرة بل الوقوع دل عليها فلم يكن للاختصاص مدلول
ونحن إنما أثبتنا العلم بالصفات من الدلائل وإذا ثبتت هذه المسئلة أخذنا
في المسئلة الثانية وهو كون الرب تعالى مريداً بإرادة قديمة.
فنقول قد
قام الدليل على أن معنى المريد هو ذو الإرادة كما قام الدليل على أن معنى
العالم هو ذو العلم فنقول أما أن يكون الرب سبحانه مريداً لنفسه أو بإرادة
وإذا تحقق أنه مريد بإرادة فإما أن تكون الإرادة قديمة وإما أن تكون حادثة
فإن كانت حادثة فلا يخلو إما أن تكون حادثة في ذاته أو في محل أو لا في
ذاته ولا في محل وقد سبق الرد على من قال بحدوث الإرادة في ذاته ويستحيل
كون الإرادة في محل ويكون الرب تعالى مريداً بها فإن المعنى إذا قام بمحل
وصف المحل به إذ من المحال وصف الشيئين بمعنى واحد قام بأحدهما دون الثاني
ويستحيل كون الإرادة لا في محل فإن الإرادة من جملة المعاني والإعراض
واحتياج الأعراض إلى المحل صفة ذاتية لها ومن المحال ثبوتها دون الوصف
الذاتي ولو لم تحل في محل لكانت قائمة بذاتها والقائم بالذات قابل للمعنى
فحينئذ تكون الإرادة قابلة للمعنى ولا يكون فرق بين حقيقة الجوهر وبين
حقيقة العرض حتى لو جوز استغناء العرض عن المحل في وقت من الأوقات جاز في
كل وقت ولو جوز لجنس من الأجناس أو لنوع من الأنواع لجاز لكل نوع وجنس ولو
جوز ذلك أيضاً للزم تجويز قيام جوهر بمحل فإنه كما يستثنى الإرادة والغناء
والتعظيم عن جنس من المعاني حتى لا يفتقر إلى محل جاز أن يستثنى جنس من
الجوهر حتى يحتاج إلى محل وكل ذلك محال.
ثم نقول هب أنا ارتكبنا هذه
الاستحالة وتصورنا إرادة لا في محل فمن المريد بها ومن المعلوم أن نسبتها
إلى القديم والحادث على وتيرة واحدة.
فإن قيل يوصف بها القديم لأن القديم لا في محل والإرادة لا في محل فهي به
أولى.
قيل
ولو قيل يوصف بها الحادث لأن الإرادة حادثة والجوهر حادث والحادث بالحادث
أولى والمناسبات بين الحوادث تتحقق ولا مناسبة بين القديم والحادث بوجه ما
ثم أخذتم قولكم لا في محل بالاشتراك فإن معنى قولنا القديم لا في محل أي
لا في مكان ومعنى قولنا الإرادة لا في محل أي لا في متمكن وفرق بين المكان
والمحل فلم توجد المناسبة شاملة للطرفين بمعنى متفق عليه مشترك فيه فلا
مناسبة أصلاً هذا كمن يقول الجوهر لا في محل والإرادة لا في محل فوصف
الجوهر بها أولى ونقول قد قام الدليل على أن كل حادث اختص بالوجود دون
العدم وبوقت وقدر دون وقت وقدر كان المحدث مراداً والإرادة شاركت جميع
الحوادث في هذه القضية فإنها اختصت بوقت ومقدار من العدد دون وقت ومقدار
فيستدعي إرادة أخرى والكلام فيها كالكلام في هذه فيجب أن يتسلسل والقول
بالتسلسل باطل.
قالت المعتزلة نعم إثبات إرادات لا في محل على خلاف وضع الأعراض والمعاني
لكن الضرورة ألجأت إلى التزام ذلك.
قيل
أنه لا وجه لإنكار الإرادة كما قال الكعبي لأنه يوجب أن تكون الأفعال غير
اختيارية شبيهة بالأفعال الطبيعية عند أهل الطبائع ولا وجه لإثبات كونه
مريداً لذاته لأن الصفات الذاتية وجب تعميمها فهي عامة التعلق وحينئذ وجب
تعلق كونه مريداً بالفواحش والقبائح وذلك باطل كما سيأتي ولا وجه لإثبات
إرادة قديمة لأنه يؤدي إلى إثبات إلاهين قديمين كما سبق أن الاشتراك في
القدم يوجب الاشتراك في الإلهية ولا وجه لإثبات كونها حادثة قائمة بذات
الباري ولا لإثبات كونها قائمة بذات أخرى لما سبق من المعنى فتعين أنها لا
في محل فالضرورة العقلية ألجأت إلى تعيين هذا القسم من الأقسام ونحن لم
نبعد النجعة في ذلك مع إثبات الفلاسفة عقولاً مفارقة للأجسام قائمة
بذواتها وهي مبادئ الموجودات ومع إثبات جهم وهشام علوماً حادثة لا في محل
ومع إثبات الأشعرية تكليماً لا في محل لأن ذلك الكلام الذي في ذات الباري
تعالى لم ينتقل إلى سمع موسى عليه السلام والذي سمعه موسى لم يكن في محل
فهم وإن لم يصرحوا بتكليم لا في محل كما صرحنا بتعظيم لا في محل غير أنهم
أثبتوا كلاماً مسموعاً والصفة الأزلية لم تنتقل وسمع موسى قد امتلى
بالتكليم حتى يقال أنه سمع كجر السلسلة.
وأما قولكم إن حدثت إرادة
فبإرادة أخرى تحدث وبتسلسل فغير مقبول لأن الإرادة لا تراد أليست إرادتنا
لو كانت مرادة بإرادة أخرى أدت إلى التسلسل فلم تستدع الإرادة جنسها.
قالت
الأشعرية الضرورة التي ادعيتم ليست الضرورة العقلية التي يضطر العقل إلى
التزامها من إبطال قسم وتعيين قسم فإنكم قدرتم من محال حتى ارتكبتم محالاً
والأقسام كلها بزعمكم محالات فلم التزمتم هذا المحال دون مذهب الكعبي في
رده الإرادة إلى العالمية والقادرية كما رددتم كونه سميعاً بصيراً إلى
كونه عليماً خبيراً على قول وهلا التزمتم مذهب النجار في رد الإرادة إلى
صفة النفي كمن قال منكم إنه سميع بصير بمعنى أنه حي لا آفة به وهلا قلتم
هو مريد لنفسه كما قال النجار على رأي ولا تلتزموا عموم التعلق إلا فيما
يصح أن يكون قادراً على ما يصح أن يكون مقدوراً له وهلا التزمتم مذهب
الكرامية في إثبات إرادات في ذاته لأن المحذور من ذلك الالتزام هو التغيير
بالحوادث والتغيير حاصل في الأحكام حسب حصوله في المعاني إذا لم يكن
مريداً فصار مريداً عندكم فإذا لم يدل تغيير الأحكام على الحدوث لم يدل
تغيير المعاني أيضاً على الحدوث أو هل قلتم هو مريد بإرادات في محل كما
قلتم هو متكلم بكلام يخلقه في محل وما الفرق بين البابين فإن الإرادة إن
أوجبت حكماً لمن قامت به فليوجب الكلام كذلك وإن كان المتكلم من فعل
الكلام على أصلكم فاصطلحوا على أن المريد من فعل الإرادة ثم يرجع الحكم
إلى الفاعل كما يرجع في كونه عدلاً يخلق العدل فكيف التزمتم أبعد الأقسام
قبولاً عن كونه معقولاً.
ثم قولكم الإرادة لا تراد تحكم باطل فإن
الإرادة من الحوادث وكل حادث اختص بمثل دون مثل فهو مراد وإن استغنى حادث
عن الإرادة استغنى كل حادث ولا يؤدي إلى التسلسل في الإرادة فإن الإرادة
الأخيرة تستند إلى خلق الباري فهي ضرورية الوجود مرادة بإرادة الباري
تعالى وإرادته قديمة لا تراد أي لا تتخصص بوقت دون وقت.
وأما التمثل
بالعقول المفارقة على رأي الفلاسفة غير سديد فإنهم أثبتوا جواهر قائمة
بذواتها قابلة للمعاني غير أنهم لم يحكموا بتحيزها وأنتم أثبتم إرادات من
جنس إرادات الحوادث وهي أعراض لا في محل فقد أخرجتموها عن أخص أوصاف
العرضية وما أجريتم فيها حكم الجوهرية.
وأما التمثل بمذهب جهم بن صفوان
وهشام فمثل حال والرد عليه كالرد عليكم والتمثل بمذهب الأشعري في تكليم
البشر غير مستقيم على أصله فإن عنده كلام الله مسموع بسمع البشر كما أنه
مرئي برؤية البشر ولم يجب من ذلك انتقال ولا تغير وزوال فطفتم على أبواب
المذاهب وفزتم بأخس المطالب.
وأما المسئلة الثالثة من شعب المسئلة
الكبرى هو القول في تعلق إرادة الباري بالكائنات كلها والمدار في هذه
المسئلة على تعين الجهة التي هي متعلق الإرادة فيرتفع النزاع والتشنيع
بذلك فنذكر المذاهب أولاً ثم نشرع في الدليل.
قالت المعتزلة القائلون
بإرادات حادثة أن الباري تعالى مريد لأفعاله الخاصة بمعنى أنه قاصد إلى
خلقها على ما علم وتتقدم إرادته على المفعول بلحظة واحدة ومريد لأفعال
المكلفين ما كان منها خيراً ليكون وما كان منها شراً لأن لا يكون وما لم
يكن خيراً ولا شراً ولا واجباً ولا محظوراً وهي المباحات فالرب تعالى لا
يريدها ولا يكرهها ويجوز تقديم إرادته وكراهيته على أفعال العباد بأوقات
وأزمان ولم يجعلوا له حداً أو مرداً.
ثم القدماء منهم قالوا إن الإرادة
الحادثة توجب المراد وخصصوا الإيجاب بالقصد إلى إنشاء الفعل لنفسه أما
العزم في حقنا وإرادة فعل الغير فإنها لا توجب ولم يريدوا بالإيجاد إيجاب
العلة المعلول ولا إيجاب التولد والإرادة عندهم لا تولد فإن القدرة عندهم
توجب المقدور بواسطة السبب فلو كانت الإرادة مولدة بواسطة السبب استند
المراد إلى سببين ولزم حصول مقدورين قادرين.
قالت المعتزلة الصفة
القديمة إذا تعلقت بمتعلقاتها وجب عموم تعلقها إذ لا اختصاص للقديم بشيء
فلو كانت الإرادة قديمة لتعلقت بكل مراد من أفعال نفسه ومن أفعال العباد
أن يريد زيد حركة ويريد عمرو سكوناً فوجب أن يكون القديم مريداً
لإرادتيهما ومراديهما وما هو مراد يجب وقوعه فيؤدي إلى اجتماع الضدين في
حالة واحدة.
قالت الأشعرية الصفة القديمة يجب تعلقها بكل متعلق على
الإطلاق أم يجب عموم تعلقها بما يصح أن يكون متعلقاً بها فإن كان الأول
فهو غير مستمر في الصفات فإن العلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل
والقدرة لا تتعلق إلا بالممكن من الأقسام والإرادة لا تتعلق إلا بالمتجدد
من الممكنات والعلم أعم تعلقاً والقدرة أخص من العلم والإرادة أخص من
القدرة والعموم لا ينقص ولا يزيد وفيما لا يتناهى من المعلومات والمقدورات
والمرادات فكل قسم لا يتناهى فيعم تعلق الصفة بما لا يتناهى مما يليق بكل
قسم ويختص بكل صفة ولو كان الإيجاب بالقدرة على نعت الإيجاد لوجد كل ما
تعلقت به القدرة فيوجد ما لا يتناهى وذلك محال بل الإرادة هي المخصصة
بالوجود المتعلقة بحال متجدد. وأما تعلق إرادة القديم بالضدين في حالة
واحدة.
قالوا لسنا نسلم أولاً أن ههنا إرادتين للضدين بل هو ما وقع في
معلوم الرب تعالى أن يقع فهو المراد وصاحبه المريد وما علم أنه لا يقع
فليس مراداً وصاحبه المتمني ويجوز تعلق الإرادة القديمة بمعنيين أحدهما
تمنٍ وشهوة والثاني إرادة.
ثم قالوا لم قلتم أن إرادة الإرادتين تقتضي
إرادة المرادين حتى يلزم الجمع بين الضدين فإنه تعالى إنما أراد إرادتيهما
من حيث وجودهما وتجددهما لا من حيث مراديهما وهو كإرادته للقدرة لا تكون
إرادة للمقدور وقدرته على الإرادة لا تكون قدرة على المراد على أصلكم
كعلمه بعلم زيد وظن عمرو وشك خالد وجهل بكر لا يكون اعتقاداً لمعتقداتهم
حتى يوصف بمتعلقات صفاتهم.
والسر في ذلك أن الإرادة القديمة لم
تتعلق إلا بوجه واحد وهو المتجدد من حيث هو حادث متجدد متخصص بالوجود دون
العدم ووقت دون وقت والإرادتان تشتركان في التجدد فتنتسبان إليها من جهة
التجدد والتخصص وهما من هذا الوجه ليسا ضدين فلم تتعلق الإرادة بالضدين
ولو قيل تتعلق الإرادة بالإرادتين جميعاً من حيث الوقوع والتجدد وبأحد
المرادين وهو الواقع منهما في المعلوم وتتعلق بعدم وقوع الآخر فهي إرادة
لوقوع أحدهما وكراهة لوقوع الآخر كان ذلك أيضاً صواباً قال الله تعالى: "
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " أي خلاف العسر كما قال "
أتنبئون الله بما لا يعلم " أي بما يعلم خلافه حتى لا يكون النفي داخلاً
في الإطلاقات.
قالت المعتزلة قد تقرر في العقول أن مريد الخير خير
ومريد الشر شر ومريد العدل عادل ومريد الظلم ظالم فلو كانت الإرادة
الأزلية تتعلق بالكائنات كلها لكان الخير والشر مراداً فيكون المريد
موصوفاً بالخيرية والشرية والعدل والظلم وذلك قبيح في حق القديم سبحانه
قال الله تعالى: " وما الله يريد ظلماً للعباد " قالت الأشعرية هذه
المقدمة التي ذكرتموها من المشهورات في عادات الناس لا من الأوليات في
قضايا العقول وإنما يختص إطرادها في بعض الصور دون البعض إذ لا يقال في
سياق ذلك أن مريد الجهل جاهل ومريد العلم عالم ومريد الطاعة مطيع ولا يقال
مريد الحركة متحرك ومريد الصلاة مصل ثم يقال في الشاهد مريد العبادة عابد
ولا يقال في الغائب مريد العبادة عابد.
ثم السر في ذلك أن الإرادة
الحادثة قد تكون ضرورية وقد تكون كسبية والضرورية منها لا توصف بالخيرية
والشرية والتكليفية إذ لا تكليف إلا على المكتسب وقد توصف بالخيرية
والشرية الجبرية كما يقال الملك يريد الخير طبعاً وجبراً والشيطان يريد
الشر طبعاً وجبراً وأما الإرادات الكسبية فتتوجه على المريد فيها وبها
التكليف فيوصف الظلم والعدل والخير والشر والطاعة والمعصية كما وصف سائر
الحركات ثم لم يلزم من ذلك طردها في الغائب فلم يصح الاستدلال.
والسر
في ذلك أن الإرادة الأزلية لم تتعلق بالمراد من أفعال العباد من حيث هو
مكلف به إما طاعة وإما معصية وإما خيراً وإما شراً بل لا يتعلق به من حيث
هو فعل العبد وكسبه على الوجه الذي ينسب إليه فإن إرادة فعل الغير من حيث
هو فعله تمن وشهوة وإنما يتعلق به من حيث هو متجدد متخصص بالوجود دون
العدم متقدر بقدر دون قدر وهو من هذا الوجه غير موصوف بالخير والشر وإن
أطلق لفظ الخير على الوجود من حيث هو وجود فذلك إطلاق بمعنى يخالف ما
تنازعنا فيه فالباري تعالى مريد الوجود من حيث هو وجود الوجود من حيث هو
وجود خير فهو مريد الخير وبيده الخير وأما الوجه الذي ينسب إلى العبد هو
صفة لفعله بالنسبة إلى قدرته واستطاعته وزمانه ومكانه وتكليفه وهو من هذا
الوجه غير مراد للباري تعالى وغير مقدور له ولما تقرر عندنا بالبراهين
السابقة أنه تعالى خالق أعمال العباد كما هو خالق الكون كله وإنما هو خالق
بالاختيار والإرادة لا بالطبع والذات فكان مريداً مختاراً لتجدد الوجود
وحدوث الموجود ثم الوجود خير كله من حيث هو وجود فكان مريد الخير وأما
الشر فمن حيث هو موجود فقد شارك الخير فهو من ذلك الوجه خير ومراد وعلى
هذا لا يتحقق في الوجود شر محض فهو تعالى مريد الوجود ومريد الخير والعبد
يريد الخير والشر وعن هذا قال الحكماء الشر داخل في القضاء والإرادة
بالعرض لا بالذات وبالقصد الثاني لا بالقصد الأول فإن الشر عندهم إما عدم
وجود أو عدم كمال الوجود وإنما الداخل في القضاء والإرادة بالقصد الأول هو
الوجود وكمال الوجود ثم قد يكون الوجود على كمال أول ومتوجه إلى كمال ثان
وقد يكون على كمال مطلق كالعقول المفارقة التي هي تامة كاملة بأعيانها في
الخير المحض الذي لا شر فيه وما هو على كمال أول أي هو بالقوة على كمال
إلى أن يصير بالفعل على كمال ثان فيقع من مصادمات أحوال السلوك من المبدأ
إلى الكمال أحوال هي شرور ومضار كما تقع أحوال هي سرور ومنافع والإرادة
الأزلية والعناية الربانية تتعلق بالأمرين والقسمين جميعاً ولكن أحد
المتعلقين على سبيل التضمن والاستتباع والعرضية ويسمى ذلك مراداً ومقصوداً
بالقصد الثاني والمتعلق الثاني على سبيل الوضع والأصالة والذاتية فيسمى
ذلك مراداً ومقصوداً بالقصد الأول هذا كما يعلم أن المقصود الكلي من إنزال
المطر من السماء نظام العالم وانتظام الوجود وذلك هو الخير مطلقاً ثم إن
خرب بذلك بيت عجوز قد أشرف على الانهدام أو ماتت العجوز وقد بلغت إلى شرف
الموت كان ذلك شراً بالإضافة لا بالأصالة وبالقصد الثاني لا بالقصد الأول
ووجود خير كلي مع شر جزئي أقرب إلى الحكمة من لا وجود له لا يقع الشر
الجزئي فإن عدمه مما يورث الفساد في نظام الموجودات فهو أكثر شراً وأشد
ضراً.
قالت المعتزلة كل آمر بالشيء فهو مريد له والرب تعالى آمر عباده
بالطاعة فهو مريد لها إذ من المستحيل أن يأمر عبده بالطاعة ثم لا يريدها
والجمع بين اقتضاء الطاعة وطلبها بالأمر بها وبين كراهية وقوعها جمع بين
نقيضين وذلك بمثابة الأمر بالشيء والنهي عنه في حالة واحدة إذ لا فرق بين
قول القائل آمرك بكذا وأكره منك فعله وبين قوله آمرك بكذا وأنهاك عنه وإذا
وقع الاتفاق بأن الله تعالى آمر عباده بالطاعة وجب أن يكون مريداً لها
كارهاً لضدها من المعصية وإذا كان الآمر بالشيء مريداً له كان الناهي عن
الشيء كارهاً له.
والذي يخص ذلك أن الآمر بالشيء يقتضي من المأمور حصول
المأمور به والإرادة تقتضي تخصيص المأمور به بالوجود ومن المحال اقتضا
الحصول لشيء واقتضا ضد ذلك منه فلو قلنا أن الباري تعالى آمراً أبا جهل
بالإيمان وأراد منه الكفر أدى ذلك إلى اقتضاء الإيمان منه بحكم الآمر
واقتضاء الكفر منه بحكم الإرادة وهو محال ويخرج على هذه القاعدة استرواحكم
إلى العلم فإنه يجوز أن يأمر بخلاف المعلوم لأن العلم ليس فيه اقتضاء وطلب
وإنما هو يتعلق بالمعلوم على ما هو به بخلاف الإرادة فإنها مقتضية فيرد
الأمر على خلاف العلم ولا يرد على خلاف الإرادة .
قالت الأشعرية
لسنا نسلم أن كل آمر بالشيء مريد حصوله بل كل آمر بالشيء عالم بحصوله مريد
له حصولاً وكل آمر يعلم حصول ضده لا يكون مريداً لحصوله فإن الإرادة على
خلاف العلم تعطيل لحكم الإرادة وتغيير لأخص وصفها وقد بينا أن أخص وصفها
التخصيص وحكمها إنما يتعلق بالمتجدد من المقدورات والمتخصص من المقدورات
فإذا علم الآمر أن المأمور به لا يحصل قط ولا يتجدد ولا يتخصص قط فيستحيل
أن يريده فإنها توجد ولا متعلق لها يتعلق ولا أثر لتعلقها وذلك محال ولو
كانت الإرادة خاصيتها أن تتعلق بالممكن فقط كالقدرة لكان جائزاً أن تتعلق
بخلاف المعلوم.
ومن العجب أن متعلق القدرة أعم من متعلق الإرادة فإن
الجائز الممكن من حيث هو ممكن متعلق القدرة والمتجدد من جملة الممكنات هو
متعلق الإرادة والمتجدد أخص من الممكن.
ثم قال بعض المخالفين أن خلاف
المعلوم غير مقدور وهو أعم فخلاف المعلوم كيف يكون مراداً وهو أخص ثم نقول
من رأيي الآمر بالشيء لا يكون مريداً لمأمور به من حيث أنه مأمور به قط
سواء كان المأمور به طاعة أو غيره وقد علم الآمر حصولها وسواء كان الآمر
بخلاف ذلك فإن جهة المأمور به هو كسب المأمور وقد بينا أن ذلك أخص وصف
للفعل سمي به المرء عابداً مطيعاً مصلياً وصائماً مزكياً حاجاً غازياً
مجاهداً والفعل من هذا الوجه لا ينسب إلى الباري تعالى فلا يكون مريداً له
من هذا الوجه بل ينسب إليه من حيث التجدد والتخصيص وما لم يكن الفعل فعلاً
للمريد لا يكون مراداً له فما كان من جهة العبد من الذي سميناه كسباً ووقع
على وفق العلم والأمر كان مراداً ومرضياً أعني مراداً بالتجدد والتخصيص
مرضياً بالثناء والثواب والجزاء وما وقع على وفق العلم وخلاف الأمر كان
مراداً غير مرضي أعني مراداً بالتجدد غير مرضي بالذم والعقاب وهذا هو سر
هذه المسئلة ومن اطلع عليه استهان بتهويلات القدرية وتمويهات الجبرية فعلى
هذا لم يكن الباري تعالى مريداً للشرور والمعاصي والقبائح من حيث أنها
شرور ومعاصي وقبائح ولا هو مريد للخيرات والطاعات والمحاسن من حيث أنها
كذلك بل هو مريد لكل ما تجدد وحدث في العالم من حيث أنها متخصصة بالوجود
دون العدم ومتقدرة بأقدار دون أقدار ومتأقتة بأوقات دون أوقات ثم ذلك
الموجود قد يقع منتسباً إلى استطاعة العبد كسباً على وفق الأمر فسمي طاعة
مرضية أي مقبولة بالثناء ناجزاً والثواب آجلاً وقد يقع على خلاف الأمر
فيسمى معصية غير مرضية أي مردود بالذم ناجزاً وبالعقاب آجلاً ولولا قدرة
العبد في الشيء لكان الفعل فعلاً متجدداً مختصاً بما خصصته الإرادة من غير
أن يقال هو خير أو شر إيمان أو كفر فالأفعال كلها من حيث تجددها واختصاصها
مرداة للباري تعالى وهي متوجهة إلى نظام في الوجود وصلاح العالم وذلك هو
الخير المحض وكانت وجوهها إلى الخير وظهورها من الخير وكان بيده الخير
وكلما ورد في القرآن من إرادة الخير المخصوص بأفعال العباد مثل قوله يريد
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولكن يريد ليظهركم إلى غير ذلك فهو
محمول على أحد معنيين إما ثناء ومدح في الحال وإما على ثواب ونعمة في
المال وإلا فالإرادة الأزلية لا تتعلق إلا بما هو متجدد من حيث أنه متجدد
فلا متجدد إلا وهو فعل للباري تعالى من حيث أنه متجدد وذلك لا ينسب إلى
العبد كما بينا في خلق الأعمال فاختصت الإرادة بأفعال الله سبحانه على
الحقيقة دون الوجوه التي تنسب إلى العبد واختص الآمر بأفعال العباد حقيقة
دون الوجوه التي تنسب إلى الحق تعالى فلم يجب تلازم الآمر والإرادة وقد
يرد الآمر بمعنى الإرادة والإرادة بمعنى الآمر فيكون الإطلاق باشتراك في
اللفظ فكان المشركون تمسكوا بهذا اللفظ حيث أخبر التنزيل عنهم " وقال
الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء " أرادوا
بذلك المشيئة بمعنى الأمر وعن هذا طالبهم بإخراج العلم بذلك وإظهار الحجة
عليهم من كتبهم وقال " إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون " إذ لم يرد
بذلك أمر ولا وجدوا في كتبهم بذلك تكليفاً فرد عليهم بإثبات المشيئة بمعنى
التخصيص بالوجود والتصريف للأمور فقال تعالى " قل فلله الحجة البالغة فلو
شاء لهداكم أجمعين "
وقد تمهل أبو الحسن وأصحابه أمثلة في جواز تعلق
الإرادة على خلاف الأمر منها أن نبياً لو علم من أحد الأمة أنه لو أمر
بعشر خصال من الخير توانى فيها ولو أمر بعشرين خصلة ثم حط عشرة منها عنه
لم يقصر فيأمره بالعشرين على إرادة امتثال العشرة فهو مأمور بخلاف المراد
ومراد بخلاف المأمور ومثل هذا قد وقع ليلة المعراج حيث أمر النبي بخمسين
صلاة ثم ردت إلى الخمس ومنها أن رجلاً لو اشتكى عند السلطان من عبيده
بعصيانهم عليه وقلة مبالاتهم فيستحضرهم الملك فيأمرهم المالك بشيء فهو
يريد مخالفتهم إياه تصديقاً لمقاله فذلك أمر على خلاف الإرادة ومنها أن
الرب تعالى أمر خليله إبراهيم بذبح الولد وهو يريد أن لا يحصل إذ لو أراد
لحصل.
وللخصوم عن هذه الأمثلة اعتذارات ولنا عنها غنية وبما سبق من
التحقيق كفاية ومن غرق في بحر الحقيقة لم يطمع في شط ومن تعالى إلى ذروة
الكمال لم يخف من حط.
وقد تمسكت المعتزلة بكلمات من ظواهر الكتاب منها
قوله تعالى " ولا يرضى لعباده الكفر " وقوله " والله يريد أن يتوب عليكم
ويريد الذين يتبعون الشهوات انم تميلوا ميلاً عظيماً " وقوله " يريد الله
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " وقوله " تريدون عرض الدنيا والله يريد
الآخرة " وقوله " وما الله يريد ظلماً للعباد " وقوله " لا يحب الله الجهر
بالسوء من القول إلا من ظلم " وقوله " سيقول الذين أشركوا " وقوله " وما
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " وأجابت الأشعرية بتأويلات وتخصيصات.
وأحسن
الأجوبة أن نقول إرادة الله ومشيئته أو رضاه ومحبته لا تتعلق بالمعاصي قط
من حيث أنها معاص كما لا تتعلق قدرته تعالى بأفعال العباد من حيث هي
أكسابهم فيرتفع النزاع ويندفع التشنيع وخرج ما قدرناه من التحقيق وإن شئت
حملت كل آية على معنى يشعر به اللفظ ويدل عليه الفحوى.
أما قوله تعالى
" ولا يرضى لعباده الكفر " أي لا يرضى لهم ديناً وشرعاً فإنه وخيم العاقبة
كثير المضرة كمن يشتري عبداً معيباً فيقول له لا أرضى هذا لك عبداً ومما
يتقوى به هذا المعنى أن الرضى والسخط يتقابلان تقابل التضاد ثم السخط لم
يكن محمولاً إلا على ذم في الحال وعقاب في المال كذلك الرضى محمول على
الثناء في الحال وثواب في المال.
وأما قوله تعالى والله يريد أن يتوب
عليكم وسائر الآيات في الإرادة محمولة على كلمة ذكرها الصادق جعفر بن محمد
رضي الله عنه أن الله تعالى أراد بنا شيئاً وأراد منا شيئاً فما أراده بنا
أظهره لنا وما أراده منا طواه عنا فما بالنا نشتغل بما أراده منا عما
أراده بنا ومعنى ذلك أنه أراد بنا ما أمرنا به وأراد منا ما علمه فكانت
الإرادة واحدة يختلف حكمها باختلاف وجه تعلقها بالمراد وهي إذا تعلقت
بثواب سميت رضى ومحبة وإذا تعلقت بعقاب سميت سخطاً وغضباً وكذلك إذا تعلقت
بالمراد على وجه تعلق العلم به قيل أراد منه ما علم وإذا تعلقت بالمراد
على وجه تعلق الأمر قيل أراد به ما أمر وإذا تعلقت بالصنع مطلقاً بالتخصيص
والتعيين من غير التفات إلى كسب العبد حتى يكون أراد منه وأراده به قيل
أراد الكائنات بأسرها ولم يقل أراد منها وأراد بها بل أرادها على ما هي
عليه من التجدد والتخصيص بالوجود دون العدم فإذاً أفعال العباد من حيث
أنها أفعالهم إما أن يقال تتعلق الإرادة بها لا على الوجه الذي ينسب إلى
العباد بل على الوجه الذي انتسب إلى الخلق إيجاداً وتخصيصاً وإما أن يقال
تعلقت الإرادة بها على الوجهين المذكورين أنه أراد بنا وأراد منا أراد بنا
ما أمر ديناً وشرعاً واعتقاداً ومذهباً وأراد منا ما علم سابقة وعاقبة
وفاتحة وخاتمة ودل على صحة هذا المعنى قوله " ولو شئنا لآتينا كل نفس
هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين " أي لما لم
يشأ الهداية لحق القول على مقتضى العلم السابق.
وقوله تعالى " وما خلقت
الجن والإنس إلا ليعبدون " أي لأمرهم بالعبادة وقيل ليخضعوا ويستسلموا كما
قال " وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً "
قالت الفلاسفة النظام في الوجود أو في العالم متوجه إلى الخير لأنه صادر عن أصل الخير والخير ما يتشوق كل شيء إليه ويتميز به وجود كل شيء والأول لما علم نظام الخير على الوجه الأبلغ في الإمكان فاض منه ما عقله نظاماً وخيراً على الوجه الأبلغ فيضاً تاماً على أتم تأدية وذلك هو العناية الأزلية والإرادة السرمدية فكان الخير داخلاً في القضاء الإلهي دخولاً بالذات لا بالعرض ثم الشر على وجوه فيقال شر لمثل النقص الذي هو الجهل والعجز والتشويه في الخلقة ويقال شر لمثل الوجع والألم والمرض ويقال شر لمثل الظلم والزنا والسرقة وبالجملة الشر بالذات هو العدم ولا كل عدم بل عدم منقص طباع الشيء من الكمالات الثابتة النوعية والطبيعية والشر المطلق لا وجود له وكذلك الشر بالذات ليس بأمر حاصل إلا أن يخبر عن لفظه ولو كان له حصول لكان شراً مطلقاً عاماً ذاتياً موجوداً وإذا تحقق له وجود فقد حصلت فيه خيرية من جهة وجوده إذ الوجود من حيث هو وجود خير فتحقق أن الشر المطلق لا وجود له إلا في اللفظ والذهن والوجود على كماله الأقصى أن يكون بالفعل وليس فيه أمر ما بالقوة أصلاً فلا يلحقه شر وأما الشر بالعرض فله وجود ما وإنما يلحق ما في طباعه أمر ما بالقوة وذلك لأجل المادة فيلحقها الأمر يعرض لها في نفسها وأول وجودها هيئة من الهيئات المانعة لاستعدادها الخاص للكمال الذي توجهت إليه فجعلها أردى مزاجاً وأعصى جوهراً لقبول التخطيط والتشكيل والتقويم فتشوهت الخلقة وانتقصت البنية لا لأن الفاعل قد حرم بل لأن المنفعل لم يقبل فربما يؤدي ذلك إلى أن يصدر من تلك البنية أخلاق رديئة وربما تستولي نفس حيوانية على نفس إنسانية فيصدر عن الشخص أفعال قبيحة واعتقادات فاسدة وأما الأمر الطارئ على الشخص من خارج فأحد شيئين أما ما يقع للمكمل وأما ما يصادم حق الكمال ومثال ذلك في النوع الإنساني العادات القبيحة التي يتربى عليه الصبي من أول نشؤه والاعتقادات الفاسدة التي يتعلم الصبي من المعلمين والأبوين وإلا فأصل الفطرة كان على استعداد صالح لولا المانع وعليه دلت الإشارات النبوية كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فالشر إذاً داخل في القضاء الإلهي بالعرض لا بالذات إذا وقع فبالحري أن يجازي مجازاة الهلاك والفساد على وجود العلة العارضة فالباري تعالى مريد للخير إرادة بالذات إذ هو مصدر للخيرات ومريد للشر إرادة بالعرض وليس مصدر الشرور وانقسمت الأمور إذا توهمت موجودة إلى خير مطلق وإلى شر مطلق وإلى خير ممزوج بشر والأخير إما أن يتساوى فيه الخير والشر أو يغلب أحدهما أما الخير المطلق الذي لا شر فيه فقد وجد في الطباع وفي الخلقة وأما الشر المطلق الذي لا خير فيه والغالب أو المساوي فلا وجود له أصلاً فبقي ما الغالب في وجوده الخير وليس يخلو عن شر فالأحرى به أن يوجد فإن لا يكون أعظم شراً من كونه فواجب أن يقتضي وجوده من حيث يقتضي منه الوجود لئلا يفوت الخير الكلي بوجود الشر الجزي وأيضاً لو امتنع وجود ذلك القدر من الشر امتنع وجود أسبابه التي تؤدي إليه بالعرض فكان منه أعظم حالاً في نظام الخير الكلي كمثل النار فإن الكون إنما يتم بأن تكون فيه نار ولن يتصور وجودها إلا على وجه تحرق وتسخن ولم يكن بد من المصادفات الحادثة أن تصادف النار ثوب فقير ناسك فتحرقه فالأمر الدائم والأكثر حصول الخير من النار أما الدائم فلأن أنواعاً كثيرة لا تستحفظ على الدوام إلا بالنار وأما الأكثر فإن أكثر أنواع الأشخاص في كنف السلامة عن الاحتراق فما كان يحسن أن يترك المنافع الأكثرية لأعراض شرية أقلية فإرادات الباري تعالى الخيرات الكائنة على مثال هذه الأشياء إرادة أولية على الوجه الذي يصلح أن يقال أرادها بالذات وبالقصد الأول وأراد الشرور الكائنة غير أولية على الوجه الذي يصلح أن يقال أرادها إرادة بالعرض وبالقصد الثاني فالخير مقتضى بالذات والشر مقتضى بالعرض وكل يقدر ولو لم يقرر الأمر على ما قررناه للزم أن يكون مصدر الخير غير مصدر الشر وذاك مذهب الثنوية.
قال
المتكلمون لا ننازعكم في اصطلاحكم على أن الخير المحض ما هو أوان الخير
المحض ممن هو وإن النظام في العالم متوجه إلى كمال في الوجود وإنما النزاع
بيننا في الخيرات التي تتعلق بأفعال العباد وإكسابهم مثل الاعتقادات
الفاسدة والجهالات الباطلة والأخلاق الردية والأفعال القبيحة أهي حاصلة
بإرادتنا دون إرادة الباري أم هي مرادة له عز وجل وما سوى ذلك من الصور
القبيحة والحيوانات المؤذية والآفات السماوية والعاهات الأرضية وما يتبعها
من الهموم والغموم والآلام والأوجاع فلا نزاع فيها أهي خيرات أم شرور ولا
نقول هي خيرات ومصالح وتحت كل منها شر ومع كل بلاء ومحنة لطف وفي كل فتنة
وآفة صلاح ولكل حيوان يؤذي خاصية ومودع في كل جسم من الأجسام منفعة ومضرة
وكل مضرة فبالنسبة إلى شيء آخر منفعة لكنا نلزمكم أمراً كلياً فإن عندكم
الوجود كله بما فيه من الروحاني والجسماني صادر عن الأول على الترتيب
المذكور صدور اللوازم عن الشيء وما كان على سبيل اللوازم فهو بالقصد
الثاني أشبه منه بالقصد الأول فما الفرق بين الشرور الواقعة في الكائنات
وكونها مقتضية بالعرض وبين أصل الكون والكائنات وحصولها على سبيل اللزوم
فليس إذاً في الوجود شيء هو مقتضى بالذات حتى يكون شيء آخر هو مقتضى
بالعرض وما ذكرتموه من حد الخير أنه يتشوقه الكل فهو الخير المحض وهو
المراد لا المريد وما سواه فليس بخير ولا مراد إذ لا يتشوقه الباري تعالى
فلم يرده ويرجع الكلام إلى شبه الطامات وقولكم أنه إذا علم النظام وأبدعه
فقد أراده فجعلتم الإرادة مركبة من سلب وإضافة أما السلب فمن جهة أنه عالم
أي غير محتجب عن ذاته بذاته وأما الإضافة فمن جهة أنه مبدأ النظام الخير
والنظام في الوجود تابع ولازم لكونه عالماً والشر في الوجود لازم وتبع
للنظام فما الفرق بين لازم ولازم وعندكم الجزئيات معلومة تتبع الكليات
والكليات معلومة تبعاً لعلمه وهي معلومة على منهاج كونها معلومة فالشر
والقبائح يجب أن تكون مرادة على منهاج كونها معلومة وقولكم الشر المحض ليس
بموجود أصلاً فإن الوجود اشتمل على الخير أو هو خير كله.
فنقول أثبتم
ترتيباً في الوجود حتى قضيتم بأن الوجود في بعض الموجودات أول وأولى وفي
بعضها لا أول ولا أولى فهلا أثبتم فيه تضاداً أيضاً حتى تحكموا بأن الوجود
في بعض الموجودات خير كله وفي بعضها شر كله وقد سمعتم من أصحاب الشرائع
إثبات الملائكة الروحانيين وذلك خير كله وإثبات الشياطين وهذا شر كله
وأصحاب الأصلين النور والظلمة يقرون عليكم السلام للإلزام وأصحاب الكلام
يلزمونكم إثبات موجودات العالم غير مستندة إلى الموجد كأنها وقعت اتفاقاً
لا قصداً أو حدثت فلتة لا إرادة واختياراً فإن كانت لا مستند لها فهي
مخلوقة لا خالق لها وإن كان مستندها خيراً محضاً فكيف يصدر الشر من الخير
وإن كان مستندها شراً محضاً فالشر المحض لا وجود له عندكم فما الجواب وكيف
الخروج عن عهدة الخطاب.
ونقول نرى العالم الجسماني مملوءاً بالبلايا
والمحن والزرايا والفتن ومشحوناً بالآفات والعاهات والطوارق والحسرات
ومتموجاً بالجهالات وفاسد الاعتقادات وأكثر الخلق على الأخلاق الذميمة
والخصال اللئيمة واستيلاء القوة الشهوية والغضبية على العقلية حتى لا تكاد
تجد في قرن من القرون إلا واحداً يقول بالحكمة الإلهية التي هي التشبه
بالإله عندكم أو فرقة يسيرة ترتسم بالمراسيم الشرعية التي هي امتثال
الأوامر الإلهية عندنا بل أكثرهم " صم بكم عمي فهم لا يعقلون " " وما
وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين " " وقليل من عبادي الشكور
" فكيف يستمر لكم معاشر الفلاسفة أن البشر في العالم بمطلقه لا يوجد
وبأكثره لا يتحقق وقد صادفتم الوجود على خلاف ما قررتم فاعتبروا النفوس
الإنسانية والغالب على أحوالها من العلم والجهل وعلى أخلاقها من الحسن
والقبيح وعلى أقوالها من الصدق والكذب وعلى أفعالها من الشر والخير تعلمون
أن الشر في العالم الجسماني أغلب وأكثر خصوصاً في النفوس الإنسانية
وبالجملة فحيث ما وجدنا الفطرة والتقدير الإلهي غالباً على الاختيار
والاكتساب البشري كان الغالب هو الخير والصلاح وحيث ما وجدنا الاختيار
والاكتساب غالبين كان الغالب هو الشر والفساد فعاد الأمر إلى أن لا شر في
الأفعال الإلهية فإن وجد فيها شر فبالإضافة إلى شيء دون شيء وإنما يدخل
الشر في الأفعال الإنسانية الاختيارية وهي أيضاً من حيث أنها تستند إلى
إرادة الباري سبحانه خير ومن حيث أنها تستند إلى اكتساب العبد تكتسب اسم
الشر غير أن الشرائع قد وردت بإثبات الشياطين وإثبات رأسهم إبليس اللعين
وليس يمكن إنكار ذلك بعد ثبوت الصدق في أقوالهم وأخبارهم بالبينات الواضحة
والمعجزات الباهرة وقد اعترف بوجودها قدماء الحكماء قالوا ما من شيء جزى
في العالم إلا ويتحقق له في عالم آخر آمر كلي فبالحرارة الجزية استدل على
نار كلية وبالعقل الجزي يستدل على عقل كلي وكذلك سائر الأمور فبالشر الجزي
في العالم يستدل على شر كلي وكذلك أثبت المجوس وأصحاب الاثنين للعالم
أصلين هما منبع الخير والشر والنفع والضرر وهما النور والظلمة كما سبق ذكر
مذاهبهم وقد استوفيناها في كتابنا الموسوم بالملل والنحل وبالجملة
الفلاسفة منازعون في ثلاثة أحوال أولها نفي محض موجود هو أصل الشر بالذات
لا بالعرض والثاني كون الخير في النوع الإنساني أكثر وأغلب والثالث إثبات
موجودات لا مستند لها على طريق الإيجاد بالذات بالقصد الأول وما لم تثبت
هذه الأصول لم يتم لهم ما ذكروه والله أعلم وأحكم.
القول في الكلام
حصرناه في ثلث قواعد أحديها إثبات كون الباري تعالى متكلماً بكلام أزلي
والثانية في أن كلامه واحد والثالثة في حقيقة الكلام شاهداً وفي أحكامه.
القاعدة الثانية عشرة
في كون الباري متكلماً بكلام أزليولما لم نجد في الملة الإسلامية من يخالفنا في كون الباري تعالى متكلماً بكلام قدمنا هذه المسئلة وإن جرت العادة بتقديم المسئلة الأخيرة ولم يخالفنا في ذلك إلا الفلاسفة والصابية ومنكرو النبوات وطرق متكلمي الإسلام تختلف.
فطريق الأشعرية أن قالوا دل العقل على كون الباري تعالى حياً والحي يصح منه أن يتكلم ويأمر وينهي كما يصح منه أن يعلم ويقدر ويريد ويسمع ويبصر فلو لم يتصف بالكلام أدى إلى أن يكون متصفاً بضده وهو الخرس والعي والحصر وهي نفائس ويتعالى عنها.
والذي يحقق هذه الطريقة قولهم قد ثبت بدليل العقل أنه ملك مطاع ومن حكم الملك أن يكون منه أمر ونهي كما دل تردد الخلق في صنوف التغايير والحوادث والجائزات على كون الباري تعالى قادراً عالماً دل تردد الخلق في صنوف الأمر والنهي على أمر الباري ونهيه وكما جرى في ملكه تقديره جرى على عباده تكليفه وكما تصرف في الموجودات الجبرية جبراً وقهراً تصرف في الموجودات الاختيارية تكليفاً وتعريفاً.
وقد سلك الأستاذ أبو
إسحاق الاسفرائيني رحمه الله منهاجاً آخر فقال دلت الأفعال بإتقانها
وإحكامها على أنه تعالى عالم ويستحيل أن يعلم شيئاً ولا يخبر عنه فإن
الخبر والعلم يتلازمان فلا يتصور وجود أحدهما دون الثاني ومن لا خبر عنده
عن معلومه لا يمكنه أن يخبر غيره عنه ومن المعلوم أن الباري يصح منه
التكليف والتعريف والإخبار والتنبيه والإرشاد والتعليم فوجب أن يكون له
كلام وقول يكلف ويعرف ويخبر وينبه بذلك فإذاً ثبتت هذه الدلائل كونه
متكلماً.
فنقول إما أن يقال هو متكلم لنفسه أو متكلم بكلام ثم إن كان
متكلماً بكلام فإما أن يكون كلامه قديماً أو حادثاً وإن كان حادثاً فإما
أن يحدث في ذاته أو في محل أو لا في محل ولا قائل بكونه متكلماً لنفسه من
المعتزلة وغيرهم إذ لو كان يعم تعقله أزلاً وأبداً ولا قائل بكلام يخلقه
لا في محل لأن في نفي المحل نفي الاختصاص وفيه إبطال التفرقة بين ما يقوم
بنفسه وبين ما لا يقوم بنفسه ومن قال هو متكلم بكلام يحدثه في ذاته كما
صارت إليه الكرامية فقد سبق الرد عليهم ومن قال هو متكلم بكلام يخلقه في
محل كما صار إليه المعتزلة فقد خالف قضية العقل فإن الكلام لو قام بمحل
لكان المحل متصفاً به دون غيره من الفاعل وغيره كما لو تحرك متحرك بحركة
يخلقها الله لم يرجع أخص وصفها إلى الفاعل وكذلك سائر الأعراض فبقي أنه
متكلم بكلام قديم أزلي يختص به قياماً ووصفاً وذلك ما أثبتناه.
قالت الفلاسفة والصائية قولهم الحي يصح منه الاتصاف بالكلام لأنه لو لم يتصف به لاتصف بضده وكثيراً يطردون هذا الدليل في سائر الصفات وهي دعوى مجردة لا برهان عليها إلا الاسترواح إلى الشاهد ونحن نورد عليكم نقضاً لهذه القاعدة حتى يتبين أن اعتذاركم عن النقض اعتذارنا عن هذه الدعوى وذلك أن الحي يصح منه الاتصاف بالحواس الخمس ثم الثلث منها كالشم والذوق واللمس يصح في الشاهد ويصح وصفه بها والاتصاف بها كما يصح منه الاتصاف بالسمع والبصر والكلام ثم لم يجز طرد ذلك كله في الغائب ولا يقال أنه لو لم يتصف بها كان موصوفاً بضدها بل يجب أن يقال يتعالى الحق عنها وعن أضدادها كذلك قولنا في السمع والبصر والكلام واعتذاركم أن اتصال الأجرام بتلك الحواس شرط في الشاهد كذلك اعتذارنا أن البنية واتصال الأجرام واصطكاكها شرط في الشاهد فلا يجوز أن يوصف الحي بها ولا بضدها جميعاً وكثيراً ما يكون من الصفات كمالاً في الشاهد ونقصاناً في الغائب فبقيت الحجة الأولى عرية عن البرهان وأما قولكم أن الرب تعالى ملك مطاع ذو أمر ونهي فمسلم لكنكم معاشر المتكلمين أنتم منازعون في إثبات الكلام له هو أمر ونهي على وجه يتصف به إما قياماً بذاته وإما قياماً بغيره فإنا نقول هو ملك مطاع وله أمر ونهي لا على طريق قولي بل على طريق فعلي وهو تعريف المأمور خبراً أن الفعل المأمور به واجب الإقدام عليه بأن يخلق له معرفة ضرورية أن الأمر كذلك إما أن يتكلم بكلام يخلقه في محل أو يتكلم أزلاً وأبداً بكلام يسمع في حال ولا يسمع في حال فهو من أمحل المحال وهذا لأن تصريفه تعالى جواهر الخلائق بالفعل على وجه ينقاد له طوعاً وكرهاً لما خلقه له وقدره فيه نازلاً منزلة القول ألستم تقرون في كتابكم " ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين " ثم ذلك ليس خطاباً قولياً بل تصريفاً وتسخيراً بحيث لو عبر عن تلك الحالة من التصريف والانقياد كان ذلك أمراً بالإتيان وجواباً بالطاعة لا بالعصيان وعلى ذلك المنهاج سيرة العباد في البلاد وتيسيره السير فيها حالة لو عبر عنها بالقول لكان خطاباً لهم " سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين " وكذلك كل موجود أبدعه الباري تعالى بلا زمان وبلا مادة ولا آلة بحيث لو عبر عن حال الإيجاد والإبداع كان ذلك أمراً بالتكون كما قال " إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون " وإلا فالخطاب القولي مستحيل أن يتوجه إلى العدم وهذا في المبدأ كذلك نقول في حال الكمال أعني كمال حال الإنسان من النبوة والرسالة أو كمال حال الملائكة من الروح والواسطة فهو يصلون إلى حال في النفوس الشريفة والمناسبات اللطيفة بين الأرواح المجسدة المشخصة وبين الروحانيات البسيطة المجردة بحيث لو عبر عن تلك الحالة كان ذلك وحياً وتنزيلاً وخطاباً وسؤالاً وجواباً وتقريباً وإيجاباً وقالوا أيضاً لو قدر للباري تعالى كلام فلم يخل من أحد الأمرين إما أن كان من جنس كلام البشر أو لم يكن فإن كان لم يخل أيضاً من أحد الأمرين إما أن كان من جنس الكلام اللساني أو من جنس النطق النفساني ويستحيل أن يكون كلامه مثل الكلام في اللسان فإن هذا مركب من حروف منظومة والحروف تقطيع أصوات والأصوات اصطكاك أجرام والباري سبحانه تعالى عن أن يكون جرماً أو مركباً من جرم وجسم وإن قدر كلامه يخلقه في محل لم يكن ذلك الكلام قولاً له بل فعلاً ونحن نوافقكم في التعريفات الفعلية على أن هذا التقدير يستحيل أيضاً فإن ذلك المحل إما أن يشتمل على مخارج الحروف أو لا يشتمل فإن اشتمل وجب أن يتحقق فيه حياة فيكون ذا بنية وهيئة إنسانية فيكون إنساناً فيكون الباري تعالى متكلماً بلسان بشر فيكون قد تصور بصورة البشر فيلزم أن يقال أنه يسمع بسمعه ويبصر ببصره كما نطق بلسانه ويأخذ بيده ويمشي برجله وهذا هو الحلول الذي ذهب إليه أصحابه وإن لم يشتمل على مخارج الحروف كانت أصواتاً مجردةً لا حروفاً منظومةً فلا يكون كلامه من جنس كلامنا بل الأصوات الحادثة من حفيف الشجر ودوي الماء وصوت الرعد يكون كلاماً له وذلك خلاف الكلام المتعارف فإن قيل أن كلامه من جنس النطق النفساني فهو باطل أيضاً فإن النطق النفسي على وجهين أحدهما ما هو مأخوذ في اللسان عربياً وعجمياً وغير ذلك إلى ما يعلم من المعلمين فيكون
ذلك تقديرات حروف في الخيال وتصويرات كلمات في الوهم ويستحيل أن يكون كلامه تعالى من جنس المأخوذات والثاني ما هو مركوز في طبيعة النفس من التمييز والتفكير بحيث يعبر عنه باللسان فيكون هو مأخوذ اللسان وذلك أيضاً مستحيل لأن ذلك يقتضي ترديد الخواطر وتقليب الأفكار والابتداء من مبدأ والانتهاء إلى منتهى وذلك كله محال فثبت أنه لا يجوز أن يكون من جنس كلام البشر وما كان خارجاً عن كلام البشر لا يجوز أن يثبت بالاستدلال على كلام البشر لأن غير الجنس لا يدل على الجنس فيخرج على هذا قولكم أن كل عالم يجد من نفسه خبراً عن معلومه فإن هذا وإن سلم في الشاهد فكيف يستمر لكم طرده في الغائب مع تسليمكم أن الخبرين لا يتماثلان إلا في اسم الخبرية وكذلك قولكم أن كل ملك مطاع يجب أن يكون صاحب أمر بالتكليف فإنه مسلم في الشاهد على ما ذكرنا غير مطرد في الغائب على المنهج الذي هو معتاد في الشاهد وهذا الإلزام ليس يختص بمسئلة الكلام بل متوجه على من يجميع بين الشاهد والغائب في معنى لا يشتركان فيه جنساً ومماثلة ويكون حكمه حكم من يجمع بين قرص الشمس ومنبع الماء لا في معنى يشتركان كان فيه جنساً وماثلةً بل بمجرد اسم العين المطلق عليهما بالاشتراك.ذلك تقديرات حروف في الخيال وتصويرات كلمات في الوهم ويستحيل أن يكون كلامه تعالى من جنس المأخوذات والثاني ما هو مركوز في طبيعة النفس من التمييز والتفكير بحيث يعبر عنه باللسان فيكون هو مأخوذ اللسان وذلك أيضاً مستحيل لأن ذلك يقتضي ترديد الخواطر وتقليب الأفكار والابتداء من مبدأ والانتهاء إلى منتهى وذلك كله محال فثبت أنه لا يجوز أن يكون من جنس كلام البشر وما كان خارجاً عن كلام البشر لا يجوز أن يثبت بالاستدلال على كلام البشر لأن غير الجنس لا يدل على الجنس فيخرج على هذا قولكم أن كل عالم يجد من نفسه خبراً عن معلومه فإن هذا وإن سلم في الشاهد فكيف يستمر لكم طرده في الغائب مع تسليمكم أن الخبرين لا يتماثلان إلا في اسم الخبرية وكذلك قولكم أن كل ملك مطاع يجب أن يكون صاحب أمر بالتكليف فإنه مسلم في الشاهد على ما ذكرنا غير مطرد في الغائب على المنهج الذي هو معتاد في الشاهد وهذا الإلزام ليس يختص بمسئلة الكلام بل متوجه على من يجميع بين الشاهد والغائب في معنى لا يشتركان فيه جنساً ومماثلة ويكون حكمه حكم من يجمع بين قرص الشمس ومنبع الماء لا في معنى يشتركان كان فيه جنساً وماثلةً بل بمجرد اسم العين المطلق عليهما بالاشتراك.
قال المتكلمون الطريقة المختارة عندنا في
إثبات الصفات الاستدلال بالدلائل التي نجدها في الشاهد فإنا بالأحكام
استدللنا على العلم وبوقوع الأفعال على القدرة والاختصاص ببعض الجائزات
على الإرادة كذلك نستدل بالتكاليف على العباد ذوي العقول والاستطاعة على
أن الباري تعالى آمر ناه وله الأمر والنهي والوعد على إتيان المأمور به
والوعيد على فعل المنهي عنه وهذا لا يتصور من جنس الفعل وإنما يتحقق من
جنس القول فيستدل بالوجوه التي في الصنائع والأفعال على انه تعالى خالق
وبالوجوه التي في الشرائع والأحكام على أنه تعالى آمر " ألا له االخلق
والأمر تبارك الله رب العالمين " ووجه الاستدلال من الشرائع والأحكام أن
التكليف اقتضاء وطلب المأمور به والاقتضاء قضية معقولة وراء العلم والقدرة
والإرادة أما وجه المباينة بينها وبين العلم أن العلم يتعلق بالمعلوم على
ما هو به وليس في تعلقه اقتضاء المعلوم بل هو تبيين وانكشاف ومن خاصيته أن
يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل والاقتضاء والأمر لا يتعلق بالواجب
والمستحيل وأما وجه مباينته للقدرة أن القدرة صالحة للإيجاد فقط وإنما
تتعلق بالممكن ويستوي في تعلقه كل ممكن في ذاته والاقتضاء والأمر والنهي
لا يتعلق بكل ممكن ليحصل وجوده وأما وجه مباينته الإرادة أن الإرادة صالحة
للتخصيص ببعض الجائزات فقط وإنما تتعلق بالمتجدد من جملة الممكن ويستوي في
تعلقه كل متجدد متخصص والاقتضاء والطلب يختلف من جهة تحدده وقد بينا أن من
الأشياء ما يراد ولا يؤمر به ومنها ما يؤمر به ولا يراد بل الإرادة من حيث
الحقيقة لا تتعلق إلا بفعل المريد والأمر والاقتضاء لا يتعلق من حيث
الحقيقة إلا بفعل الغير فكيف تتحدان حقيقة وخاصية فثبت أن مدلول التكاليف
من حيث الحدود والأحكام قضية وراء العلم والقدرة والإرادة وذلك ما عبرنا
عنه بالقول والكلام وعبر التنزيل عنه بالأمر والخطاب ومن وجه آخر نقول
الحركات الاختيارية التي اختصت بتصرفات الإنسان ثلث حركة فكرية وهي من
تصرفات عقله وفكره وحركة قولية وهي من تصرفات نفسه ولسانه وحركة فعلية وهي
من تصرفات بدنه والقوى البدنية وما من حركة من هذه الحركات إلا والله فيها
حكم بالأمر والنهي فإن الفكرية تشتمل على حجة وشبهة وصواب وخطأ وحق وباطل
والقولية تشتمل على صدق وكذب وإقرار وإنكار وحكمة وسفه والفعلية تشتمل على
خير وشر وطاعة ومعصية وصلاح وفساد وقد قام الدليل على أن الباري تعالى حكم
عدل وله حكم وقضية في كل حركة من هذه الحركات وذلك الحكم إما أن يكون
فعلاً من الأفعال وإما أن يكون قولاً من الأقوال واستحال أن يكون فعلاً
يفعله فإن كل فعل فهو مسبوق بحكمه بل ذلك الفعل دليل على حكمه وحكمه مدلول
فعله وكما أن الحركات الضرورية دلت باختصاصها ببعض الجائزات دون البعض على
علمه وإرادته وقدرته كذلك الحركات الاختيارية دلت باختصاصها ببعض الأحكام
دون البعض على حكمه وأمره وقضيته وقولكم أن التصريف بالفعل نازل منزلة
التكليف بالقول مسلم فيما يرجع إلى أفعال غير اختيارية للإنسان لكن
الأفعال الاختيارية لما استدعت ممن له الخلق والأمر حكماً واقتضاء وطلباً
فكل فعل وتصريف من الخالق يدل على حكمه واقتضائه وذلك بعينه هو غرضنا
ومرادنا.
فنقول ذلك الفعل من وجه إحكامه دل على علم الفاعل ومن وجه
وقوعه دل على قدرته ومن وجه اختصاصه دل على إرادته ومن وجه تردده بين
الجواز والحظر والإباحة دل على أن للباري تعالى فيها حكماً وقضية ثم ذلك
الحكم قد يكون أمراً وقد يكون نهياً وقد يكون إباحة فقد سلمتم المسئلة من
حيث منعتموها.
فنقول إثبات الكلام والأمر والنهي يبنى على جواز
انبعاث الرسل فإن من أحال كونه متكلماً يلزمه أن ينكر كونه مرسلاً رسولاً
ومن جوز على الله تعالى أن يبعث رسولاً فذلك الرسول يبلغ رسالات الله لا
محالة ورسالاته أوامره ونواهيه وحملها على فعل يفعله في محل بحيث يفهم من
ذلك الفعل أنه يريد من المكلف فعلاً ويكره فعلاً تسليم المسئلة فإن تلك
الإرادة التي تتعلق بفعل الغير حتى يفعله إرادة تضمنت اقتضاءً وحكماً وإلا
كانت تمنياً وتشهياً وذلك الذي يسمى أمراً ونهياً وسميتموه إرادة وكراهية
فإذاً مدلول ذلك الفعل الذي أشاروا إليه هو الذي نسميه الشرع كلاماً
وأمراً ونهياً وعلى منهاج الحكم الفلسفية إذاً انتهى الإبداع والخلق إلى
غاية تهيأت الأمزجة المعتدلة لقبول النفس الناطقة التي تفكر بالروية
وتتصرف بالاختيار وكان من المختارين بهذه النفس على روية الحق والصواب
بالاختيار الأفضل والاجتناب عن الأرذل ومنهم من يتوانى ويكسل حتى يبطل ذلك
الاستعداد ويستعمله في جانب الباطل والخطأ واختيار الأرذل والاجتناب عن
الأفضل وجب أن يكون من عند الحكيم حكم على هذه النفس الناطقة وهي ملتبسة
في هذا البدن الجسماني وحكم عليها وهي مفارقة له فذلك الحكم الأول هو الذي
نعني به بأنه أمر ونهي وهذا الحكم الثاني هو الذي نعني به أنه وعد ووعيد
ومن نفى هذا الحكم فقد نفى كونه ملكاً مالكاً لملكه فيكون له خلق ولا يكون
له أمر ويكون في جانب المخلوق كله جبراً ولا يكون اختياراً ثم يلزم أن
تكون النفوس الناطقة كائنة فاسدة لا معاد لها ولا كمال ولا جزاء على
أفعالها ولا ثواب وذلك يبطل قضية الحكمة ونحن نرى من النفوس الحيوانية ما
لا يتفاهم بعضها من بعض إلا بإحدى من الحواس الأربع وهي اللمس والذوق
والشم والبصر ومنها ما يتفاهم بها وبالسمع أيضاً ثم منها ما يكون له مجرد
الصوت من غير لحن ومنها ما يكون له مع صوته لحن ثم من أصحاب الألحان ما
يكون من ذوات الحروف المقطعة ومنها ما لا يكون إلى أن يبلغ الأمر والحال
إلى ترصيع الكلمات من الحروف وترتيب الحروف في الكلمات فيكون ذلك دلالة
على ما في النفوس الناطقة وليس كل مرتبة من هذه المراتب من جنس المرتبة
التي قبلها لكنها كمالات النفوس بعد كمالات إلى أن تبلغ إلى النفس الناطقة
الإنسانية فيحدس منها أن مرتبتها لما كانت فوق مرتبة سائر النفوس دل ذلك
على أن مرتبة النفوس الروحانية والأرواح الملكية فوق مرتبة هذه النفوس في
التفاهم وكما لا تكون المرتبة التي للناطقة من جنس المرتبة التي للطير
والبهائم كذلك لا تكون المرتبة التي للملائكة الروحانية من جنس المرتبة
التي لنا بل تكون أشرف وألطف غير أنا بهذا الجنس استدللنا على ذلك النوع
كما استدللنا بنوع من الحدس في الأمور الغائبة على نوع من الحدس في أمور
الغيب إلى أن يصل الكمال إلى حد من الخليقة فيقف الترتيب في المراتب
فيستدل بذلك على أن أمر من له الخلق والأمر فوق الأوامر النطقية الإنسانية
والفكر العقلية وأنه بوحدته فكر في معنى كل كلام ونطق وخبر واستخبار وأمر
ونهي ووعد ووعيد وإن سمعا يسمع كلامه فوق كل سمع هو مفطور للحرف والصوت
كما أن سمعاً يسمع الحروف والصوت فوق سمع هو مجبول بمجرد الصوت فنحن إذا
لم نستدل بجنس على جنس بل بجنس على ما هو فوق الجنس فبطل استرواحهم إلى
التقسيم الذي ذكروه.
ثم نقول آنفاً ألستم تقولون أن واجب الوجود من حيث
يعطي العقل في المعقول عاقل ومن حيث يعطي البدء في المبدأ قادر ومن حيث
يعطي النظام على أتم وجوه الكمال مريد فهلا قلتم أنه من حيث يعطي النطق
الروحاني للمفارقات والنطق النفساني لذوات القوالب آمر متكلم ثم هلا حملتم
كلامه وأمره على ما حملتم علمه وقدرته وإرادته فيصير التنازع واحداً بيننا
ويرجع الأمر إلى مسئلة الصفات فما الذي عدا مما بدا وكيف اشتملت مسئلة
الكلام على محال لم تشتمل عليه مسئلة العلم والقدرة عندكم.
قالت
المعتزلة نحن نوافقكم على أن الباري تعالى متكلم لكن حقيقة المتكلم من فعل
الكلام فهو فاعل الكلام في محل بحيث يسمع ويعلم أنه كلامه ضرورة لأنه لو
كان المتكلم من قام به الكلام كما ذهبتم إليه وجب أن يكون كلامه إما
قديماً وإما حادثاً وإن كان قديماً ففيه إثبات القديمين ويرجع القول إلى
مسئلة الصفات ومما يختص بهذه المسئلة من الاستحالة أنه لو كان قديماً وهو
أمر ونهي لزم أن يكون كلاماً مع نفسه من غير مأمور ولا منهي ومن المحال
الذي لا يتمارى فيه أن القول بأنا أرسلنا نوحاً إلى قومه ولا نوح ولا قومه
إخبار عما ليس كما هو فهو مع استحالته كذب ومع كذبه محال وقوله اخلع نعليك
لموسى ولا موسى ولا طور ولا الوادي المقدس طوى خطاب المعدوم والمعدوم كيف
يخاطب وكذلك جميع ما في القرآن من الأوامر والنواهي والأخبار فوجب أن يكون
الكلام يحدث عند حدوث المخاطب في الوقت الذي يصل الخطاب إليه فيكون الكلام
حادثاً ثم إما أن يحدث في ذاته كما صارت إليه الكرامية فيكون محلاً
للحوادث وذلك باطل وإما أن يحدث لا في محل أو في محل ولا بد من محل فإنه
حرف والحرف تقطيع صوت والصوت في الجسم متصور فتعين أنه في جسم.
قالت
الأشعرية بنيتم مذهبكم على قاعدتين أحديهما تسليمكم كون الباري تعالى
متكلماً والثانية أن حد المتكلم وحقيقته من فعل الكلام فأما الأولى فلو
نازعكم الصابي والفيلسوف في كونه متكلماً فما دليلكم في ذلك عليهما وعندكم
الكلام فعل الباري تعالى كسائر الأفعال ولا يرجع إليه حكم الكلام إلا أنه
فاعل صانع فما الدليل على أنه متكلم أعني يوصف بمعنى يقوم بمحل آخر فما
الفرق بين مذهبكم وبين مذهب من قال أنه يخلق فعلاً يفهم عند ذلك أنه تعالى
يريد من العبد فعلاً أو يكرهه وإن أضيف إليه الكلام كان مجازاً كما قال
تعالى خطاباً للسماء والأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين فلم
يجز من حيث الحقيقة كلام هو اقتضاء وأمر وإيجاب من الله تعالى ولا تسلم
وائتمار واستيجاب من السماء والأرض من حيث القول.
قالوا طريقنا في
إثبات كونه متكلماً هو المعجزات الدالة على صدق قول الأنبياء عليهم السلام
وهم الصادقون المخبرون عن الله تعالى أنه قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا.
قيل
لهم قد سددتم على أنفسكم هذه الطريقة بوجوه أحدها أنكم زعمتم أنه لو لم
يبعث الله رسولاً كان على العاقل البالغ في عقله وجوب معرفة الله تعالى
وعلى الباري تعالى وجوب ثوابه فلو لم يبعث الله رسولاً فبم كنتم تثبتون
كونه متكلماً والثاني مصيركم إلى أن الكلام فعل من الأفعال فما دليلكم على
أنه فعل ذلك الفعل الخاص إذ ليس كل مقدور فهو واقع بفعل الله تعالى
والثالث زعمتم في الإرادة أنها مخلوقة لا في محل وفي الكلام أنه مخلوق في
محل وفي الأمرين جميعاً يرجع الحكم الأخص إلى الباري تعالى فما الفرق بين
البابين.
ثم نقول ليس يشك العاقل أن الكلام معنى من المعاني سواء كان
ذلك المعنى عبارة منظومة من حروف منظومة وأصوات مقطعة أو كان صفة نفسية
ونطقاً عقلية من غير حرف وصوت وكل معنى قائم بمحل وصف المحل به لا محالة
وذلك المعنى من حيث هو مخلوق مفعول ينسب إلى الفاعل ومن حيث هو معنى قام
بمحل فينسب إلى المحل فمحل المعنى موصوف به لا محالة فالذي وصف الفاعل به
هو وجه حدوثه منتسباً إلى ذاته القابلة له الموصوفة به وهذان وجهان
معقولان ليس يتمارى فيهما عاقل فجعلهما وجهاً واحداً حتى يكون معنى كونه
فاعلاً هو معنى كونه موصوفاً به خروج عن المعقول ومكابرة العقل ولا يرتفع
المعنى المعقول بالاصطلاح على أن معنى المتكلم هو الفاعل للكلام.
ومما
يدل على ذلك دلالة واضحة أن الكلام عند الخصم عبارة عن حروف منظومة وأصوات
مقطعة ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن الصوت أعم من الكلام فإن كل كلام
عنده صوت وليس كل صوت كلاماً ثم الصوت إذا قام به سمي المحل مصوتاً ولا
يرجع حكم الصوت إلى فاعل الصوت حتى يقال الباري تعالى إذا خلق أصواتاً في
محل هو مصوت والكلام الذي هو أخص كيف يرجع حكمه إليه حتى يقال هو متكلم
بكلام يخلقه في محل بل يرجع حكم الصوت من حيث هو معنى من المعاني إلى
المحل ويرجع حكم الفعل من حيث هو فعل من الأفعال إلى الفاعل كذلك الكلام
الذي هو أخص منه فيا عجباً بأن صار أخص صار حكمه أعم أو ليست الحركة إذا
قامت بمحل سمي بها متحركاً سواء كانت الحركة ضرورية أو اختيارية ثم إذا
خصصت الحركة بأن كانت أصواتاً تسمع أو حروفاً تفهم أو كلمات تعقل انقطع
حكمها عن المحال وعاد ما يجب اختصاصه بالمحل إلى الفاعل الذي لا ينسب إليه
إلا الأعم فعرف من هذه الوجوه أن اختصاص الكلام بالمحل الذي قام به لم
يبطل ومن الدليل على ذلك أن من سمع كلاماً من الغير علم على القطع والبتات
أنه المتكلم به ولا يقف معرفة ذلك على معرفة كونه فاعلاً بل ربما لا يخطر
بباله كونه فاعلاً أصلاً وعن هذا انتسب إليه القول فيقال قال ويقول وهو
قائل وبخطاب الأمر والنهي يخاطب قل ولا تقل ويفرق الفارق ضرورة فرقاً
معقولاً بين قولهم قل وبين قولهم افعل فإن مساق قولهم قل هو بعينه مساق
قولهم تحرك واسكن وقم واقعد وإن كان المعنى في الموضعين مخلوقاً متكسباً
بالوجهين كما عرفت ثم رجع أخص وصف الحركة إلى المحل الذي قامت به الحركة
كذلك القول ينبغي أن يرجع أخص وصفه إلى المحل الذي قام به وهذا قاطع لا
جواب عنه ونحرر هذا المعنى.
ونقول العرضية أعم من الكونية والكونية أعم
من الحركية والحركة أعم من الصوت والصوت أعم من الحروف والحروف أعم من
الكلام ثم يجب وصف المحل بكونه موصوفاً يعرض وذلك العرض بعينه كون والكون
بعينه حركة والحركة بعينها صوت والصوت حرف والحرف كلام فيجب أن يوصف المحل
بكونه ذا كلام ومتكلماً كما وجب وصفه بكونه ذا حركة ومتحركاً ومن جعل
المعنيين معنى واحداً وسمى النسبتين نسبة واحدة كان عن المعقول خارجاً.
ومما
يتمسك به في دفع قولهم المتكلم من فعل الكلام أن الله تعالى لو خلق في
المبرسم وبعض الممرورين أن قال بلسانه قمت وقعدت لم يخل الحال من أحد
أمرين إما أن يقال يكون المتكلم بهذه الحروف المنظومة والأصوات المقطعة هو
خالقها وفاعلها فيلزم أن يكون الباري قائلاً قمت وقعدت وإما أن يقال
المتكلم بهذه الكلمات هو صاحب البرسام دون غيره فقد بطل قولهم أن المتكلم
ليس من قام به الكلام بل من فعل الكلام دون غيره.
ثم إنا نلزمهم عليه
عجائب أخر نشرحها ها هنا فإنه قد وقع الاتفاق على أن المعجزات من فعل الله
تعالى غير مكتسبة لجنس الحيوان والبشر ثم من المعجزات ما هو نطق وقول
يخلقه الله في جماد أو حيوان مثل تكليم الشاة المسمومة لا تأكل مني فإني
مسمومة ومثل تسبيح الحصى في يد الرسول عليه السلام وشهادته برسالته ومثل
مكالمته الضب ومثل منطق الطير وتأويب الجبال " يا جبال أوبي معه والطير "
إلى غير ذلك مما قد استفاضت الأخبار الصحيحة بها فكل ذلك فعل الله تعالى
فالمتكلم عندهم من فعل الكلام فيجب أن يكون الباري تعالى متكلماً بها إذ
كان فاعلاً لها وهو محال ثم إن النجارية وافقت الأشعرية على أن الباري
خالق أعمال العباد فيلزمهم أن يقولوا هو قائل بقولهم متكلم بكلامهم إذ كان
فاعلاً لها.
ومما نلزمهم أن القادر على الحقيقة من يكون قادراً على
الضدين والكلام معنى له أضداد فإذا قالوا المتكلم من فعل الكلام يلزمهم أن
يقولوا الساكت من فعل السكوت حتى لو خلق سكوتاً في محل كان ساكتاً ولو خلق
أمراً في محل كان آمراً ولو خلق خبراً في محل كان مخبراً ثم من الأوامر ما
يكون خيراً ومنه ما يكون شراً ومن الأخبار ما يكون صدقاً ومنه ما يكون
كذباً فيلزمهم إضافة الكل إلى الله تعالى وهو محال وأما ما أورده على قدم
الكلام واتحاده فنفرد لهذين الإشكالين مسئلتين ونتكلم عليهما بما فيه مقنع
إن شاء الله تعالى لكنا نعارضهم ها هنا بما التزموه مذهباً.
فنقول
من المعلوم الذي لا مرية فيه أن النطق اللساني مركب من حروف والحروف
مقطعات من أصوات وما من حرف يتفوه به الإنسان وينطق به اللسان ألا ويفنى
عقيب ما وجد وينعدم كما يتجدد ويعقبه حرف آخر إلى أن يصير مجموع الحرفين
والثلاث وأكثر كلمة ويصير مجموع الكلمتين والثلاث وأكثر كلاماً مفهوماً
مشتملاً على معنى من المعاني معلوم لولا ذلك المعنى لم يسم الحروف
والكلمات كلاماً فإذا كل الحروف والكلمات محالها اللسان وكل المعاني
والمفهومات محالها الجنان وبمجموع الأمرين سمي الإنسان ناطقاً ومتكلماً
حتى لو وجدت الحروف اللسانية منه دون المعاني الجنانية سمي مجنوناً لا
متكلماً إلا بالمجاز ولو وجدت المعاني الجنانية منه دون الألفاظ اللسانية
سمي مفكراً لا متكلماً إلا بالمجاز وإن كان بين الموضعين فرق وهو كالفرق
بين المؤمن بلسانه دون قلبه وبين المؤمن بقلبه دون لسانه غير أنا نسامحهم
ها هنا حتى يتضح الحق من السقيم ثم نعطي كل قسم حقه.
فنقول لولا مطابقة
الألفاظ اللسانية معانيها النفسانية لم يكن كلاماً أصلاً بل لولا سبق تلك
المعاني في النفس على العبارات في اللسان لم يمكن أن يعبر عنها ولا أن يدل
عليها ويوصل إليها وهذا في حقنا ظاهر فما قولكم في حق الباري سبحانه
أفيخلق حروفاً وكلمات في محل ولا دلالة لها على معان وحقائق أم لها دلالة
فإن كان الأول فهو من أمحل المحال وإن كان الثاني حقاً فما مدلول تلك
العبارات وأين ذلك المدلول ولا جائز أن يقال مدلولها علم الباري تعالى
وعالميته فإن العلم لا اقتضاء فيه والمدلول ها هنا يجب أن يكون اقتضاءً
وطلباً والعلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به وخلاف المعلوم لا يقتضيه العلم
وقد يكون من القول ما يقتضي خلاف المعلوم والعلم من حيث هو علم يتعلق
بالواجب والجائز والمستحيل والاقتضاء والطلب لا يتعلق بالواجب والمستحيل
وكذلك الإرادة لا تصلح أن تكون مدلولة لها فإن الإرادة وإن تخيل فيها
اقتضاء وطلب فلا يتخيل فيها خبر واستخبار ووعد ووعيد وقد تحقق في العبارات
هذا المعنى وكذلك القدرة لا تصلح أن تكون مدلولة لها فإنها بخاصيتها بعيدة
عن الاقتضاء والطلب أعني طلب الفعل من الغير فلا بد إذا من مدلول قطعاً
ويقيناً وإلا خلت العبارات عن المعاني وطاحت في إدراج الأماني كسير
السواني وذلك المدلول يجب أن يختص بالقائل اختصاص وصف وصفة حتى تستقيم
الدلالة وتتضح الإمارة ثم ذلك المدلول أهو واحد وحدة الموصوف أو كثير كثرة
العبارات أو هو قديم قدم الموصوف أو محدث حدوث العبارات فذلك محل الاشتباه
في الموضعين ومجال النظر في الطرفين وملتطم الأمواج عند التقاء البحرين.
القاعدة الثالثة عشر
في أن كلام الباري واحد
ذهبت الأشعرية إلى أن كلام الباري تعالى واحد وهو مع وحدته أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد وذهبت الكرامية إلى أن الكلام بمعنى القدرة على القول معنى واحد وبمعنى القول معان كثيرة قائمة بذات الباري تعالى وهي أقوال مسموعة وكلمات محفوظة تحدث في ذاته عند قوله وتكلمه ولا يجوز عليها الفناء ولا العدم عندهم وذهبت المعتزلة إلى أن الكلام حروف منظومة وأصوات مقطعة شاهداً وغائباً لا حقيقة للكلام سوى ذلك وهي مخلوقة قائمة بمحل حادث إذا أوجدها الباري تعالى سمعت من المحل وكما وجدت فنيت وشرط أبو علي الجبائي البنية المخصوصة التي يتأتى منها مخارج الحروف شاهداً وغائباً ولم يشترط ذلك ابنه أبو هاشم في الغائب.قالت الأشعرية إذا قام الدليل على أن
الكلام معنى قائم بذات الباري تعالى وكل معنى أو صفة له فهي واحدة وكل ما
دل على أن علمه وقدرته وإرادته واحدة فذلك يدل على أن كلامه واحد وذلك أنه
لو كان كثيراً لم يخل إما أن يكون أعداداً لا تتناهى وإما أن يكون أعداداً
متناهية فإن كان أعداداً لا تتناهى فهو محال لأن ما حصره الوجود من العدد
فهو متناه وإن اقتصر على عدد دون عدد فاختصاصه بالبعض دون البعض يستدعي
مخصصاً والقديم لا اختصاص له والصفة الأزلية إذا كانت متعلقة وجب عموم
تعلقها بجميع المتعلقات لأن نسبتها إلى الكل وإلى كل واحد نسبة واحدة فلئن
تعلقت بواحدة تعلقت بالكل وإن تخلفت عن واحدة تخلفت عن الكل وخصومنا لو
وافقونا على أن الكلام في الشاهد معنى في النفس سوى العبارات القائمة
باللسان وأن الكلام في الغائب معنى قائم بذات الباري تعالى سوى العبارات
التي نقرؤها باللسان ونكتبها في المصاحف لوافقونا على اتحاد المعنى لكن
لما كان الكلام لفظاً مشتركاً في الإطلاق لم يتوارد على محل واحد فإن ما
يثبته الخصم كلاماً فالأشعرية تثبته وتوافقه على أنه كثير وأنه محدث مخلوق
وما يثبته الأشعري كلاماً فالخصم ينكره أصلاً فكيف يصح منه كلامه في وحدته
وكونه أزلياً قديماً ولكن ليس يتكلم الخصم في هذه المسئلة إلا على سبيل
الإلزام وإيراد الإشكال.
قالت المعتزلة لو كان كلامه تعالى واحداً
لاستحال أن يكون مع وحدته أمراً ونهياً وخبراً واستخبار ووعداً ووعيداً
فإن هذه حقائق مختلفة وخصائص متباينة ومن المحال اشتمال شيء واحد له حقيقة
واحدة على خواص مختلفة نعم يجوز أن يكون معنى واحد يشمل معاني مختلفة
كالجنس والنوع فإن الحيوانية معنى واحد يشمل معاني مختلفة وكذلك الإنسانية
تشمل أشخاصاً مختلفة لكن لا يتصور وجود المعنى الجنسي إلا في الذهن
ويستحيل أن يتحقق في الوجود شيء واحد هو أشياء مختلفة وحقيقة واحدة هي
بعينها حقائق مختلفة حتى تكون حقيقة واحدة علماً وقدرة وإرادة وسواداً
وحركة فإن ذلك يرفع الحقائق ويؤدي إلى السفسطة فنسبة الأمر والنهي والخبر
والاستخبار والوعد والوعيد وهي حقائق مختلفة إلى الكلام كنسبة العلم
والقدرة والإرادة والسواد والحركة وهي حقائق مختلفة إلى شيء واحد وذلك
محال وإذا كان لكل واحد من أقسام الكلام حقيقة خاصة فليكن لكل واحد منهما
صفة خاصة وإن قلتم أن الكلام اسم جنس يشمل أنواعاً صحيح غير أن الجنس لا
يتحقق له وجود ما لم يتنوع بفصل يميز نوعاً عن نوع والنوع لا يتحقق له
وجود ما لم يتشخص بعارض يميز شخصاً عن شخص وذلك كالعرض المطلق من حيث هو
عرض لا يتحقق له وجود ما لم يتنوع بكونه لوناً واللون لا يتحقق له وجود ما
لم يتعين بكونه سواداً معيناً وإلا فالعرض ليس له ذات على انفراده قائم
بجوهر ثم يكون هو بعينه علماً وقدرة ولوناً وسواداً وطعماً وأنتم أثبتم
الكلام قائماً بذات الباري تعالى على هذا المنهاج أنه حقيقة واحدة هي
بعينها أمر ونهي وخبر واستخبار وذلك محال.
قالت الأشعرية حكي عن بعض
متقدمي أصحابنا أنه أثبت لله خمس كلمات هي خمس صفات الخبر والاستخبار
والأمر والنهي والنداء فإن سلكنا هذا المسلك اندفع السؤال وارتفع الإشكال
لكن المشهور من مذهب أبي الحسن أن الكلام صفة واحدة لها خاصية واحدة
ولخصوص وصفها حد خاص وكونه أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً خصائص أو لوازم
تلك الصفة كما أن علمه تعالى صفة واحدة تختلف معلوماتها وعي هي مختلفة في
أنفسها فيكون علماً بالقديم والحادث والوجود والعدم وأجناس المحدثات وكما
لا يجب تعدد العلم بعدد المعلومات كذلك لا يجب تعدد الكلام بعدد المتعلقات
وكون الكلام أمراً ونهياً أوصاف الكلام لا أقسام الكلام كما أن كون الجوهر
قائماً بذاته قابلاً للعرض متحيزاً ذا مساحة وحجم أوصاف نفسية للجوهر وإن
كانت معانيها مختلفة كذلك كون الكلام أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً
أوصاف نفسية للكلام وأن كانت معانيها مختلفة وليس اشتمال معنى الكلام على
هذه المعاني كانقسام العرض إلى أصنافه المختلفة وانقسام الحيوان إلى
أنواعه المتمايزة فأقسام الشيء غير وأوصاف الشيء غير وكل ما في الشاهد
للكلام من الأقسام فهو في الغائب للكلام أوصاف والذي يحقق ذلك أن المعنى
قد يكون واحداً في ذاته ويكون له أوصاف هي اعتبارات عقلية ثم الاعتبارات
العقلية قد تكون من جهة النسب والإضافات وقد تكون من جهة الموانع واللواحق
أليست الإرادة قد تسمى رضى إذا كان فعل الغير واقعاً على نهج الصواب وقد
تسمى هي بعينها سخطاً إذا كان الفعل على غير الصواب كذلك يسمى أمراً إذا
تعلق بالمأمور به ويسمى نهياً إذا تعلق بالمنهي عنه وهو في ذاته واحد
وتختلف أساميه من جهة متعلقاته حتى قيل أن الكلام بحقيقته خبر عن المعلوم
وكل عالم يجد من نفسه خبراً عن معلومه ضرورة فإن تعلق بالشيء الذي وجب
فعله سمي أمراً وإذا تعلق بالشيء الذي حرم فعله سمي نهياً وإن تعلق بشيء
ليس فيه اقتضاء وطلب سمي خبراً واستخباراً فهذه أسامي الكلام من جهة
متعلقاته كأسامي الرب تعالى من جهة أفعاله.
ثم نقول ليس بيد الخصم في
هذه المسئلة إلا مجرد الإلزام على مذهب من قال بوحدة الكلام وإلا فمن أنكر
أصل الكلام النفسي كيف يسمع منه القول في الوحدة ولكن العجب من هذا الملزم
أنه التزم ما هو أمحل المحال في وحدة الحال التي هي مصححة الأحوال فإنه
قال عالمية الباري سبحانه وقادريته حال وله حال توجب كونه عالماً قادراً
فقد أثبت حالاً لها خصوصية العلم والقدرة وهي واحدة في نفسها وراء الذات
فكيف يستبعد ممن يثبت كلاماً هو أمر ونهي وخبر وهو في نفسه واحد مختلف
الاعتبار والفلاسفة الذين هم أشد إنكاراً للكلام الأزلي ووحدته أثبتوا
عقلاً واحداً في ذاته ووجوده وتفيض منه صور لا تتناهى مختلفة ربما تختلف
أساميه باختلاف الصور والفيض عندهم كالتعلق عند المتكلم والعقل الأول
كالكلام في وحدته واختلاف الكلام بالأمر والنهي كاختلاف الفيض بالصور.
وأوضح
من ذلك مذهبهم في المبدأ الأول لا يتكثر بتكثر الموجودات اللازمة والصفات
والأسماء إما إضافة وإما سلب وإما مركبة من إضافة وسلب فهلا قالوا في
الكلام كذلك وهلا أثبتوا كلاماً أزلياً على منهاج إثباتهم له عناية أزلية
حتى يكون هو المبدأ وإليه الرجعى تكليفاً على أفعال عباده فيكون له الخلق
في الأول والأمر في الثاني ويرجع الكل إليه " لله الأمر من قبل ومن بعد
وإليه يرجع الأمر كله " .
قالت المعتزلة إثبات صفات نفسية لذات
واحدة غير مستحيل لكن إثبات خواص مختلفة وصفات متضادة لشيء واحد هو
المستحيل ومن المعلوم أن الأمر والنهي يتضادان ولهما خاصيتان مختلفتان
فإثبات ذلك لكلام واحد محال ونحن لا ننكر اختلاف الأسامي لشيء واحد
لاختلاف الوجوه والاعتبارات لكنا ننكر اختلاف الخواص المتباينة لشي واحد
ولا نشك أن كون الكلام أمراً ونهياً ليس من جملة النسب والإضافات فإن
الصفات الإضافية تتحقق عند الإضافة ولا يتحقق عند رفع الإضافة ويتطرق
إليها التبدل والتغير وليس كون الكلام أمراً ونهياً مما يتحقق عند الإضافة
بل هما من أخص أوصاف الكلام سواء لاحظنا جانب المتعلق أو لم نلاحظ وكذلك
لو رفعنا المتعلق عن الوهم لم يخرج الكلام عن كونه أمراً ونهياً وخبراً
واستخباراً والعلم بالقديم والحادث علم بالشيء على ما هو به وهو صفة صالحة
لدرك ما يعرض عليه سواء كان قديماً أو حادثاً وجوداً أو عدماً والذي
يوازيه في تعلقه تعلق الأمر بمأمور معين وتعلقه بمأمور آخر فاختلاف
المأمورين كاختلاف المعلومين ثم اختلاف المعلومين لا يستدعي اختلاف
العلمين كذلك اختلاف المأمورين لا يستدعي ولا يستدعي اختلاف الأمرين لكن
كلاماً هو في نفسه أمر وهو في نفسه نهي اختلاف وصفين متضادين لشيء واحد
وهو محال ونظيره العرض في شموله أقسام الأعراض المختلفة الخواص إذ يستحيل
أن يكون للعرض ذات محققة على حيالها وهي في ذواتها علم وقدرة وحياة ولون
وكون وقولكم أن الكلام مختلف الأوصاف لا مختلف الأقسام غير صحيح بل الأمر
والنهي والخبر والاستخبار أقسام الكلام والكلام منقسم إلى ذلك إذ كل قسم
ممتاز بخاصيته وحقيقته عن القسم الآخر واسم الكلام كالجنس لها لا كالموصوف
بها ومن أمحل ما ذكرتموه قولكم ما هو أقسام في الشاهد فهو أوصاف في الغائب
والحقائق كيف تتبدل والمعقولات كيف تتفاوت وهل ذلك إلا رفع الحقائق وحسم
الطرائق.
وأما إلزام الحال فالجواب عنه أن المصحح للمختلفات المتضادات
لشيء واحد غير وثبوت المختلفات المتضادات لشيء واحد غير فإن الحياة مصححة
للعلم والجهل والقدرة والعجز والإرادة والكراهة إلى غير ذلك من المعاني
التي يشترط في ثبوتها الحياة ولا يلزم ذلك ثبوت المختلفات المتضادات لحي
واحد ونحن إذا أثبتنا حالاً فهي مصححة أو في حكم المصحح ولم نثبت مختلفات
متضادة لشيء واحد فهذا هو الفرق.
وربما يجيب المتفلسف عن إلزام الفيض
المختلف عن العقل الواحد فيقول أنا أقول كما أن العقل واحد ففيض العقل
أيضاً واحد لكن القوابل والحوامل تختلف فيختلف الفيض باختلاف المفيض
كالشمس إذا أشرقت على زجاجات مختلفة الألوان أعطت كل زجاجة لوناً خاصاً
لائقاً بلونها القابل فتعدد الصور واختلافها إنما حصل من جانب المفيض لا
من جانب الفائض وأنتم أثبتم كلاماً واحداً وهو في نفسه أمر ونهي وخبر
واستخبار فتعدد الخواص واختلافها فيه إنما حصل من جانب المتعلَق لا من
جانب المتعلِق فلم تستقم التسوية بين البابين بالتعلق والفيض.
وأما
كلامنا في المبدأ ووجوب الصفات له فأبعد في باب التنزيه عن الكثرة وأعلى
في منهاج التقديس عن اختلاف الخواص له والصفات كلها راجعة إلى ذات واحدة
هي واجبة الوجود بذاتها ووجودها مستند الموجودات كلها من غير أن يثبت له
منها كمال أو يحدث له صفة وهو تعالى بكمال جلاله عديم الاسم والصفة من حيث
ذاته وإنما يقال له اسم وصفة من حيث آثاره فقط وآثاره فاعليته الصادرة عنه
لامعاً بل على ترتيب الأول والثاني من غير أن يحدث كمال في ذاته لم يكن أو
يستكمل من حادث كمالاً كان جل جلاله بذاته وتقدست أسماؤه لصفاته.
قالت الأشعرية نحن لا نثبت الحقائق المختلفة والخواص المتباينة لكلام واحد إنما يلزمنا التضاد بين أمرين يتقابلان من كل وجه فيتضادان فأما إذا لم يتقابلا بل اختلفت المتعلقات واختلفت الوجوه فلا يبعد اجتماعهما في حقيقة واحدة ونحن لو قلنا الأمر بالشيء والنهي عن ضده أو الأمر بالشيء والنهي عن شيء آخر أو أمر شخص واحد بشيء ونهي شخص آخر عن ذلك الشيء لا يستحيل وكذلك إذا اختلف الزمان والمكان والوجه والاعتبار لم يحصل التضاد فلم يلزم الاستحالة وهذا إن ألزم علينا التضاد وإن ألزم علينا الاختلاف بين الحقيقتين دون التضاد فالجواب عنه أن اجتماع مثل ذلك في شيء واحد من وجوه مختلفة غير مستحيل فإن الجوهر يوصف بأنه متحيز وقابل للأعراض وذو حجم ومساحة ونهاية وهي صفات وأحوال ووجوه واعتبارات مختلفة وما استحال اجتماعها في حقيقة الجوهرية وقد قدمنا الفرق بين الأقسام وبين الأوصاف وقولهم أن كون الكلام أمراً ونهياً وخبراً أقسام الكلام إذ يقال الكلام ينقسم إلى كذا أو إلى كذا وكل قسم إنما يتميز عن قسم بأخص وصفه في قول صحيح في الكلام شاهداً فإن الكلام القولي في اللسان أو النطق النفساني في الذهن من جملة الأعراض التي يستحيل بقاؤها ولا تتحد ذاته وتتعدد جهاته فتعدد الكلام بتعدد المتعلقات فصارت تلك الجهات أقساماً وانفصل كل قسم عن قسم بأخص وصف له بعد الاشتراك في حقيقة الكلامية كالعلوم المختلفة إذا تعلقت بمعلومات مختلفة كانت أقساماً مختلفة وامتاز كل علم عن قسمه بأخص وصفه بعد الاشتراك في حقيقة العلمية ثم إذا خصص الكلام بعلم قديم أو عالمية أزلية لم يلزم اتحاد الخصائص في ذات واحدة بل العلم الأزلي في معنى علوم مختلفة نائباً مناب الكل من غير أن تتكثر ذاته أو تختلف خواصه وكذلك الكلام الأزلي في حكم الأمر والنهي والخبر والاستخبار نائباً مناب الكل من غير أن تتكثر ذاته أو تختلف خواصه وهذا معنى قولنا الأقسام في الكلام الشاهد كالأوصاف في الكلام الغائب ثم بم تنكرون على من يقول الكلام معنى واحد حقيقته الخبر عن المعلوم ثم التعبير عن ذلك المعنى إذا كان المعلوم محكوماً فعله بالأمر أو محكوماً تركه بالنهي وإن كان في وقت قد وجد المعلوم وانقضى كان التعبير عنه عما كان وإن كان في وقت لم يوجد المعلوم بعد وسيوجد كان التعبير عنه عما سيكون فالأقسام المذكورة ترجع إلى التعبيرات بحسب الوجوه والاعتبارات وإلا فالكلام الأزلي واحد لا كثرة فيه فاختلاف الخواص وتضاد المعاني فكان قبل خلق آدم التعبير عن معلوم الخلافة في ثاني الحال " إني جاعل في الأرض خليفة " وبعد إرسال نوح وانقراض عصره كان التعبير عن معلوم الرسالة في ماضي الحال " إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه " ولو عبر عن حال موسى قبل وجوده بالواد المقدس كان على صيغة الخبر عما سيكون وإذا عبر عن حاله وهو بالواد المقدس كان على صيغة الأمر " اخلع نعليك " فالاختلافات كلها راجعة إلى التعبيرات عن الكلام الذي هو وفق المعلوم حتى لو قدرنا لأنفسنا نطقاً عقلياً سابقاً على وجود المخاطب باقياً على ممر الدهور كان المعبر عنه على حقيقة واحدة لا يتبدل والتعبيرات عنه على أقسام مختلفة لا تتماثل ولو قدرنا لنفوسنا نطقاً عقلياً مطابقاً لإدراك عقلي عالياً على الدهر والزمان بحيث نسبتهما إلى الماضي والحاضر والمستقبل نسبة واحدة لم يشك أن الاختلاف لم يرجع إلى كثرة معان في ذاته بل يرجع إلى ما يختلف بالأزمان ألم تسمع قوله تعالى وتقدس يخبر في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عن حال عيسى عليه السلام عما سيكون في القيامة بقوله عز من قائل " وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله " أو ليس عبر في المستقبل بالماضي وبعد لم تقم القيامة ولم يحشر الناس ولم يحضر عيسى عليه السلام ولكن لما كان القول الحق متعالياً عن الزمان كان ما سيوجد كأن قد وجد وكان نسبة الخطاب إليه وهو في ذلك الوقت كنسبته إليه وهو في هذا الوقت ومن أمكنه أن يرفع الزمان من صميم قلبه هان عليه إدراك المعاني العقلية وسهل عليه معرفة تعلق العلم الأزلي بالمعلومات والأمر الأزلي بالمأمورات وعلم أن الاختلاف راجع إلى العبارات والتعبيرات انظر كيف نشير إلى لمحات الحقائق على لسان الفريقين وإن كانا بمعزل عن دقائق
الطريقين وأنى لهم تصور نزول الروحانيات وتشخصها بالجسمانيات
كما أخبر التنزيل عنه " فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً " وكيف
يستقيم على مذهب المتكلم تمثل الروح بالشخص البشري أبان تعدم الروح ويوجد
الشخص وليس ذلك من التمثل في شيء أو بان يستعمل الروح شخصاً موجوداً
بشرياً ولم يكن ذلك تمثلاً أيضاً بل تناسخاً وإذا لم يمكنه تقرير التمثل
والتشكل أعني تمثل الروحاني بالجسماني كيف يمكنه تصور الأمر الأزلي يتمثل
اللسان العربي تارة واللسان السرياني طوراً حتى يجب أن يقال كلام الله كما
يجب أن يقال هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم ثم لباس جبريل يتبدل ولا تتبدل
حقيقته التي هو بها جبريل ولباس الكلام الأزلي يتبدل ولا تتبدل حقيقته
التي هو بها كلام وأمر ونهي واحد أزلي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره
حتى يسمع كلام الله حق في حق المشرك المستجير " ويا موسى إني اصطفيتك على
الناس برسالاتي وبكلامي " صدق في حق الكليم المستنير فبين الكلامين فرق ما
بين القدم والفرق وبين السمعين صرف ما بين الولاية والصرف ولو كان الكلام
في الموضعين حروفاً منظومة أصواتاً مقطعة بطل الاصطفاء على الناس وحصل
التساوي واستماع الناس والخناس ولكن حكم الكليم في خطابه يا موسى حكم
الطريد في طرده يا فرعون ولكان الذي لا يسمع من موسى أسعد حالاً من موسى
إذ سمع من الشجرة التي هي جماد وفي الموضعين الكلام حروف وأصوات.طريقين
وأنى لهم تصور نزول الروحانيات وتشخصها بالجسمانيات كما أخبر التنزيل عنه
" فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً " وكيف يستقيم على مذهب
المتكلم تمثل الروح بالشخص البشري أبان تعدم الروح ويوجد الشخص وليس ذلك
من التمثل في شيء أو بان يستعمل الروح شخصاً موجوداً بشرياً ولم يكن ذلك
تمثلاً أيضاً بل تناسخاً وإذا لم يمكنه تقرير التمثل والتشكل أعني تمثل
الروحاني بالجسماني كيف يمكنه تصور الأمر الأزلي يتمثل اللسان العربي تارة
واللسان السرياني طوراً حتى يجب أن يقال كلام الله كما يجب أن يقال هذا
جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم ثم لباس جبريل يتبدل ولا تتبدل حقيقته التي هو
بها جبريل ولباس الكلام الأزلي يتبدل ولا تتبدل حقيقته التي هو بها كلام
وأمر ونهي واحد أزلي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام
الله حق في حق المشرك المستجير " ويا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي
وبكلامي " صدق في حق الكليم المستنير فبين الكلامين فرق ما بين القدم
والفرق وبين السمعين صرف ما بين الولاية والصرف ولو كان الكلام في
الموضعين حروفاً منظومة أصواتاً مقطعة بطل الاصطفاء على الناس وحصل
التساوي واستماع الناس والخناس ولكن حكم الكليم في خطابه يا موسى حكم
الطريد في طرده يا فرعون ولكان الذي لا يسمع من موسى أسعد حالاً من موسى
إذ سمع من الشجرة التي هي جماد وفي الموضعين الكلام حروف وأصوات.
قالت
المعتزلة إذا أثبتم كلاماً أزلياً فإما أن تحكموا بأن كلام الله أمر ونهي
وخبر واستخبار في الأزل وإما أن لا تحكموا به فإن حكمتم به فقد أحلتم من
وجوه أحدها أن من حكم الأمر أن يصادف مأموراً ولم يكن في الأزل مخاطب
متعرض لأن يحث على أمر ويزجر عن آخر ويستحيل كون المعدوم مأموراً.
والوجه الثاني أن الكلام مع نفسه من غير مخاطب سفه في الشاهد والنداء لشخص
لا وجود له من أمحل ما ينسب إلى الحكيم.
والثالث
أن الخطاب مع موسى عليه السلام غير الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم
ومناهج الكلامين مع الرسولين مختلفة ويستحيل أن يكون معنى واحد هو في نفسه
كلام مع شخص على معان ومناهج وكلام مع شخص آخر على معان ومناهج أخر ثم
يكون الكلامان شيئاً واحداً ومعنى واحداً.
والرابع أن الخبرين عن
أحوال الأمتين مختلف لاختلاف حال الأمتين وكيف يتصور أن تكون حالتان
مختلفتان فيخبر عنهما بخبر واحد وكيف يكون الخبر أمراً ونهياً وكيف يكون
أمر ونهي خبراً واستخباراً ووعداً ووعيداً وأنكم إن حكمتم بأن الكلام واحد
فقد رفعتم أقسام الكلام ولا يعقل كلام إلا وأن يكون إما أمراً ونهياً وإما
خبراً واستخباراً وردكم أقسام الكلام إلى أوصاف واعتبارات تارة وإلى
تعبيرات وعبارات أخرى غير سديد أما الاعتبارات العقلية فباطلة لأن المعقول
من أقسام الكلام ذوات مختلفة وحقائق متباينة فإن القصة التي جرت ليوسف
وإخوته صلوات الله عليهم أجمعين غير القصة التي جرت لآدم ونوح وإبراهيم
وموسى وعيسى فالخبر عما جرى في حق شخص كيف يكون عين الخبر الذي جرى في حق
شخص آخر والأوامر والنواهي التي توجهت على قوم أخر في دور نبي مخصوص غير
الأوامر التي توجهت على قوم أخر في دور آخر فكيف يمكنكم القول باتحاد
الأخبار كلها على اختلافها في خبر واحد والقول باتحاد الأوامر على تفاوتها
في أمر واحد ثم كيف يمكنكم الجمع بين معنى الخبر وحقيقته أنه خبر عما كان
أو سيكون من غير اقتضاء وطلب وبين معنى الأمر وحقيقته أنه اقتضاء وطلب
لأمر لم يكن حتى يكون فليس في الخبر حكم واقتضاء وليس في الأمر خبر وإنباء
وبين النوعين فرق ظاهر فكيف يمكن القول باتحادهما نعم هما يتحدان في حقيقة
الكلامية لكنهما يختلفان بالنوعية كالحيوانية والإنسانية والعرضية
واللونية فمن رد الكلام بأنواعه وأقسامه إلى الخبر فقد أبطل الاقتضاء وعطل
الحكم والطلب ومن رد الكلام إلى الأمر فقد أبطل معنى الخبر وعطل القصص ومن
المعلوم أن النوعين موجودان في جنس الكلام ومذكوران في الكتب الإلهية وأما
من رد الاختلاف والكثرة فيهما إلى العبارات فقد أبعد النجعة فإن العبارات
إن طابقت المعاني خبراً لمخبر وأمراً لمأمور ونهياً عن منهي فقد تعددت
المعاني تعدد العبارات وإن لم تطابق فليست هي تعبيرات عنها وإنما هي
عبارات لا معنى لها وذلك كلام المجانين وإما أستر وأحكم إلى تمثل الروحاني
بالجسماني وتشكل الملك بالبشر وظهور المعنى بالعبارات فذلك في أسماعنا شبه
كلمات وكلمات فارغة فما التمثل والتشكل وكيف الظهور والتبين حققوا لنا ذلك
إن كانت العبارة مشتملة على حقيقة وإلا فالمعلومات لا تحتمل أمثال هذه
المجازفات والذي عندنا أن جبريل شخص لطيف يتكاثف فيتراءى للبصر كالهوى
اللطيف الذي لا يرا فيتكاثف فيرا سحاباً أو نقول بإعدام وإيجاد لا يتمثل
ويتشخص وبالجملة جوهر واحد لا يصير جواهر إلا بانضمام جواهر إليه ونحن لا
نعقل من الجواهر إلا المتحيز والمتحيزان لا يتداخلان فلا معنى لما تمسكتم
به.
قالت الأشعرية ذهب شيخنا الكلابي عبد الله بن سعيد إلى أن كلام
الباري في الأزل لا يتصف بكونه أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً إلا عند
وجود المخاطبين واستجماعهم شرائط التكليف فإذا أبدع الله العباد وأفهمهم
كلامه على قضية أمر وموجب زجر أو مقتضى خبر اتصف عند ذلك بهذه الأحكام فهي
عنده من صفات الأفعال بمثابة اتصاف الباري تعالى فيما لا يزال بكونه
خالقاً ورازقاً فهو في نفسه كلام لنفسه أمر ونهي وخبر وخطاب وتكليم لا
لنفسه بل بالنسبة إلى المخاطب وحال تعلقه وإنما يقول كلامه في الأزل يتصف
بكونه خبراً لأنا لو لم نصفه بذلك خرج الكلام عن أقسامه ولأن الخبر لا
يستدعي مخاطباً فإن الرب تعالى مخبر لم يزل عن ذاته وصفاته وعما سيكون من
أفعاله وعما سيكلف عباده بالأوامر والنواهي.
وعند أبي الحسن الأشعري
كلام الباري تعالى لم يزل متصفاً بكونه أمراً ونهياً وخبراً والمعدوم على
أصله مأمور بالأمر الأزلي على تقدير الوجود ثم قال في دفع السؤال إذا لم
يبعد أن يكون المأمور به معدوماً لم يبعد أن يكون المأمور معدوماً وعضد
ذلك بأنا في وقتنا مأمورون بأمر الله تعالى الذي توجه على المأمورين في
زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يبعد أن يتأخر وجود المأمور عن
الأمر بسنة لم يبعد أن يتأخر عنه بأكثر ولم يزل.
والحق أن هذا
الإشكال لا يختص بمسئلة الأمر بل هو جار في كل صفة أزلية تتعلق بمتعلقها
أزلاً أنها كيف تتعلق بالمعدوم أليس الله تعالى عالماً قادراً والعالم
معدوم وكيف يتعلق العلم والقدرة بنفي محض وعدم صرف لفعلي تقدير الوجود
فكيف يتصور التقدير في حق الباري والتقدير ترديد الفكر وتصريف الخواطر
وذلك من عمل الخيال والوهم أم يتعلق بالوجود حقيقة والوجود محصور متناه
ونحن نعتقد أن معلوماته ومقدوراته لا تتناهى وإنما يتصور ذلك فيما لم يوجد
ويمكن أن يوجد أم تقرر أن العلم صفة صالحة لدرك كل ما يعرض عليه من غير
قصور والقدرة صالحة لإيجاد كل ما يصح وجوده من غير تقاصر ثم ما يصح أن
يعلم ويجوز أن يوجد لا يتناهى فعلى هذا المعنى نقول المعلومات والمقدورات
لا تتناهى والمتعلق من حيث المتعلق راجع إلى صلاحية الصفة للكل ومن حيث
المتعلق راجع إلى صحة المعلوم والمقدور وكذلك قولنا في السمع والبصر وكونه
سميعاً بصيراً بل الجمع بين المسئلتين ها هنا أظهر فإن السمع لا يتعلق
بالمعدوم وكذلك البصر فلا يكون المعدوم مسموعاً ومبصراً بل إنما يصير
مدركاً بهما حيث يصح الإدراك وهو حال الوجود فقط لا قبله تحقيقاً كان أو
تقديراً كذلك الأمر الأزلي يتعلق بالمأمور به حتى يصح التعلق وهو حال
الوجود المتهيأ لقبوله من كونه حياً عاقلاً بالغاً متمكناً من الفعل كسائر
الصفات على السواء فليس يختص السؤال بمسئلة الكلام ووجه الحال ما قد سبق
التقرير به.
قولهم أن كلاماً لا تتحقق له أقسام الكلام غير معقول.
قلنا
وما أقسام الكلام فإن المتكلمين حصروها في ستة وسائر الناس زادوا أقساماً
مثل النداء والدعاء وزادوا في كل قسم من الأمر والنهي أقساماً مثل أمر
الندب وأمر الإيجاب ونهي التنزيه ونهي التحريم وفي كل قسم من الخبر
والاستخبار أقساماً مثل الخبر عن الماضي والمستقبل والمواجهة والمغايبة
وغير ذلك ومن تصدى ليردها إلى ستة فقد قضى بتداخل أقسام منها في أقسام
ولغيره أن يتصدى لردها إلى قسمين الخبر والأمر أما الاستخبار فلا يتصور في
حقه تعالى على موجب حقيقة الاستفهام بل حيث ورد فمعناه التقرير والإخبار
كقوله تعالى: " ألست بربكم قالوا بلى " من غير الله إلاه مع الله ومعنى
الكل راجع إلى تقرير الخطاب للمخاطب أن الأمر لا يتصور إلا كذلك وأما
الوعد والوعيد فظاهر أنهما خبران يتعلق أحدهما بثواب فسمي وعداً وتعلق
الثاني بعقاب فسمي وعيداً كما أمكن أن يرد النداء إلى الخبر يا زيد يا
عمرو أي ادعو زيداً.
وأما القسم الثاني وهو الأمر فهو والنهي لا
يجتمعان لكن كلام الله تعالى إذا تعلق بمتعلق خاص على صيغة الأمر ولم يتصل
بتركه زجراً كان ندباً وإن اتصل به زجراً سمي ذلك إيجاباً وكذلك النهي إذا
لم يرد على فعله وعيد سمي تكريهاً وإن ورد سمي تحريماً ثم هما يشتركان في
كونهما أمراً ونهياً وإن رد الأمر والنهي إلى معنى واحد وهو الأمر كان ذلك
أيضاً له وجه فإن النهي أمر بأن لا تفعل فرجع أقسام الكلام كلها إلى خبر
وأمر ثم كما أمكن رد أقسام الكلام إلى قسمين من غير نقصان في حقيقة الكلام
كذلك أمكن رد القسمين إلى قسم واحد حتى يكون كلامه على ما قررناه واحداً
وقد ورد التنزيل بتسميته أمراً بحيث يتضمن جميع الأقسام في قوله تعالى "
وما أمرنا إلا واحدة " وفي قوله " ألا له الخلق " فالخلق والأمر يتقابلان
كالفعل والقول وعن هذا أمكن الاستدلال بهذه الآية حتى يقال أن أمر الباري
غير مخلوق فإنه لو كان مخلوقاً لكان تقدير قوله ألا له الخلق وهذا من فاسد
الكلام وقد ورد أيضاً في القرآن ما يدل على أن الأمر سابق على الخلق وذلك
السبق لن يتصور إلا أن يكون أزلياً وذلك قوله سبحانه " إنما قولنا لشيء
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون " والمتكون متأخر والأمر متقدم والتقدم
على الحادث المطلق لا يكون إلا بالأزلية فتحقق من هذه الجملة أن كلامه
تعالى واحد إن سميته أمراً فهو خلاف الخلق ومقابله وإن سميته خبراً فهو
وفق العلم سواء وأنه إذا تعلق بالمأمور فيكون تعلقه مشروطاً بشرائط كما
كان تعلق سائر الصفات مشروطاً بشرائط وقد عرفت الفرق بين تعلق الصلاحية
والصحة وبين تعلق الفعل والحقيقة واندفع الإلزام بهذا الفرق.
وقولهم
إن الاختلاف والكثرة في الأخبار والأوامر لا يرجع إلى العبارات فقط إذ
العبارات لا بد وأن تطابق المعنى صحيح لكن تلك المعاني المختلفة
كالمعلومات المختلفة التي يحيط بها علم واحد وأن تلك المعلومات المختلفة
إن فرضت في الشاهد استدعت علوماً مختلفة وإن شملها اسم العلمية كذلك
الإخبار المختلفة والأوامر المختلفة وإن استدعت في الشاهد كلمات ومعاني
مختلفة فقد أحاط بها معنى واحد هو القول الحق الأزلي واختلاف الزمان
بالماضي والمستقبل والحاضر لا يؤثر في نفس القول ما يبدل القول لدي
كاختلاف الحال في المعلومات التي وجدت وستوجد لا يؤثر في نفس العلم وهذا
المعنى عسير الإدراك جداً لتكرر عهدنا بخلاف ذلك في الشاهد ولو لاحظنا
جانب العقل وإدراكه المعقول وجردناه عن المواد الجسمانية والأمثلة
الخيالية وصادفنا إدراكاُ كلياً عقلياً لا يختلف باختلاف الأزمنة ولا
يتغير بتغاير الحوادث وكذا لو استيقظنا من نوم يقظتنا هذه بمنام وطلعت
نفوسنا على مشرق المعاني والحقائق رأت عالماً من المعقولات وأشخاصاً من
الروحانيات تحدثه بأخبار وتكلمه بأحاديث لو عبر المعبر عنها بعبارات لسانه
لما وسعه يوم واحد لشرحها وبيانها ولو كتبها بقلمه لم تسعه مجلدة واحدة
لنظمها وبيانها وكل ذلك قد يراه في منامه في أقل من لحظة واحدة ويعلم
يقيناً أنه رآه حين رآه وسمع ما سمع كأنه شيء واحد ومعنى واحد لكن التعبير
عنه استدعى أوراقاً وصحائف طباقاً وكيف لا والمرء يجد من نفسه وجداناً
ضرورياً أنه إذا سئل عن إشكال في مسئلة اعتراه جوابه وحله جملة في أقل من
لحظة ثم يأتي في شرح ذلك بلسانه بعبارات حتى يمتلئ أذان وأسماع كثيرة إن
سمعها ووعاها أو يستثبته بقلمه حتى يسود بياضاً كثيراً إن سطرها وزبرها
والمعنى في الأصل كان واحداً والشرح منبسطاً والحب يكون واحداً والسنبلة
متكثرة " كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن
يشاء " ومن وجد بمشام صدقه شمائم الروحانيات ووقع في أطراف رياض المعقولات
وإن كان محوماً عليها غير واغل في خميلتها علم قطعاً أن العقل أحدي
الإدراك والنفس وحداني القول وإنما التكثر في عالم الحس يتصور والاختلاف
في عالم العبارات يتحقق وإذا كانت عقولنا ونفوسنا على هذا النمط من
التوحيد فكيف الظن بقدي الإحاطة الأزلية ووحدانية الكلمة السرمدية.
قالت
المعتزلة أجمع المسلمون قبل ظهور هذا الخلاف على أن القرآن كلام الله
واتفقوا على أنه سور وآيات وحروف منتظمة وكلمات مجموعة وهي مقروءة مسموعة
على التحقيق ولها مفتتح ومختتم وأنه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم
دالة على صدقه ولا تكون المعجزات إلا فعلاً خارقاً للعادة وكان السلف
يقولون يا رب القرآن العظيم يا رب طه يا رب يس وإنما سمي القرآن قرآناً
للجمع من قولهم قرأت الناقة لبنها في ضرعها والجمع إنما يتحقق في المفترق
والكلام الأزلي لا يوصف بمثل هذه الأوصاف ومما أجمعت عليه الأمة أن كلام
الله تعالى بين أظهرنا نقرأه بألسنتنا ونمسه بأيدينا ونبصره بأعيننا
ونسمعه بآذاننا وعليه دلت النصوص " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى
يسمع كلام الله لا يمسه إلا المطهرون " والصفة الأزلية كيف توصف بما وصفنا.
قالت
الأشعرية أنتم أول من خالف هذا الإجماع فإن عندكم كلام الله تبارك وتعالى
حروف وكلمات أحدثها في محل وكما وجدت فنيت والذي كتبناه بأيدينا فعلنا
والذي قرأناه بألسنتنا كسبنا وكذلك نثاب على فعل ذلك ونعاقب على تركه فليس
الكلام الذي بين أظهرنا كلام الله وما كان كلاماً لله فليس بين أظهرنا ولا
كان دليلاً ومعجزة ولا قرأناه ولا سمعناه بل الذي نقرأه مثل ذلك أو حكاية
عن ذلك كمن يروي شعر امرئ القيس بعد موته وعن هذه الشنعة صار أبو علي
الجبائي إلى أنه يحدث كلاماً لنفسه عند قراءة كل قارئ وعند كتابة كل كاتب
وقد جحد الضرورة وكابر العقل فإن العاقل لا يشك أن الذي يسمعه من القارئ
حروف وكلمات تخرج عن مخارجها على اختياره وليس يقارنه أمثالها حتى يكون كل
حرف حرفين وكل كلمة كلمتين وكل آية آيتين وإن كان فما محلها وقد اشتغلت
المخارج بحروفها ومن المحال اجتماع حرفين وكلمتين في محل واحد في حالة
واحدة والحروف لا وجود لها إلا على التعاقب واجتماع حرفين وكلمتين في محل
واحد غير معقول ولا مسموع ولا محسوس من جهة القارئ فهو محال.
ثم نقول
القول الحق أنا لا ننكر وجود الكلمات التي لها مفتتح ومختتم وهي آيات
وأعشار وسور ويسمى الكل قرآناً وما له مبتدأ ومنتهى لا يكون أزلياً وهو من
هذا الوجه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمى ما يقرأ باللسان قرآناً
وما يكتب باليد مصحفاً لكن كلامنا في مدلول هذه الكلمات ومقرئ هذه القراءة
أهي صفة أزلية لا حادثة وواحدة لا كثيرة أم هي هذه فقط ولا مدلول لها ولا
مقرؤ ولا مكتوب وبالاتفاق بيننا وبين الخصم كلام الله تعالى غير ما حل في
اللسان من تحريك الشفتين واللسان والحلق بل هو معنى آخر وراء ذلك فنحن
نعتقد أن ذلك المعنى واحد أزلي وأنتم تعتقدون أنه مثل هذا كثير حادث
فانقطع الاستدلال بما يعرفه أهل الإجماع وكما أن كلامه أزلي واحد عندنا
وليس ذلك بين أظهرنا كذلك هو كلام آخر في محل آخر وليس ذلك بين أظهرنا عند
الخصم فصار الاتفاق بالمقدمات المشهورة المعهودة لا اليقينية المقبولة
المشهودة وتبين أن إطلاق لفظ القرآن على القراءة والمقرؤ باشتراك اللفظ
وقد يسمى الدليل باسم المدلول ويطلق لفظ العلم على المعلوم كقوله تبارك
وتعالى " ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء " أي بمعلومه وقال إن قرآن
الفجر كان مشهوداً عني به الصلاة والقراءة فيها.
والجواب الحق أن
الآيات التي جاء بها جبريل عليه السلام منزلاً على الرسول صلى الله عليه
وسلم كلام الله كما أن الشخص الذي تمثل به جبريل وتراي وظهر له سمي جبريل
حتى يقول هذا كلام الله وهذا جبريل لأن ما أشير إليه بهاذا وهاذا هو مظهره
وأنت تقول كلامك هذا صحيح وغير صحيح ولا تشير إلى مجرد العبارة دون المعنى
بل تشير إلى العبارة على أنها مظهر المعنى وإلا فالصحة والفساد إنما
يدخلان على المعنى دون اللفظ والصواب والخطأ يرد على اللفظ دون المعنى وقد
تكون العبارة سديدة لغةً ومحواً ويكون المعنى غير سديد وبالعكس من ذلك ثم
يشار إلى العبارة ويراد به المعنى كذلك قولنا هذا كلام الله وكلام الله
بين أظهرنا ولا يمسه إلا المطهرون وقوله " يتلونه حق تلاوته " " إن علينا
جمعه وقرآنه " راجع إلى العبارة " ثم إن علينا بيانه " راجع إلى المعنى "
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون " ولو كان الكتاب من حيث هو كتاب هو القرآن
لما قال في كتاب وفي آية أخرى يتلونه صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة فتارةً
كان القرآن في كتاب وتارة كان الكتاب في القرآن ومن أدرك الطرفين على
حقيقتهما سهل عليه التمييز بين المعنيين ثم احترام الكتاب لأجل المكتوب
كاحترام البيت لأجل صاحب البيت.
قالت السلف والحنابلة قد تقرر
الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله وأن ما نقرأه ونسمعه ونكتبه عين
كلام الله فيجب أن يكون الكلمات والحروف هي بعينها كلام الله ولما تقرر
الاتفاق على أن كلام الله غير مخلوق فيجب أن تكون الكلمات أزلية غير
مخلوقة ولقد كان الأمر في أول الزمان على قولين أحدهما القدم والثاني
الحدوث والقولان مقصوران على الكلمات المكتوبة والآيات المقروءة بالألسن
فصار الآن إلى قول ثالث وهو حدوث الحروف والكلمات وقدم الكلام والأمر الذي
تدل عليه العبارات وقد حسن قول ليس منهما على خلاف القولين فكانت السلف
على إثبات القدم والأزلية لهذه الكلمات دون التعرض لصفة أخرى ورأها وكانت
المعتزلة على إثبات الحدوث والخلقية لهذه الحروف والأصوات دون التعرض لأمر
ورأها فأبدع الأشعري قولاً ثابتاً وقضى بحدوث الحروف وهو خرق الإجماع وحكم
بأن ما نقرأه كلام الله مجازاً لا حقيقة وهو عين الابتداع فهلا قال ورد
السمع بأن ما نقرأه ونكتبه كلام الله تعالى دون أن يتعرض لكيفيته وحقيقته
كما ورد السمع بإثبات كثير من الصفات من الوجه واليدين إلى غير ذلك من
الصفات الخبرية.
قالت السلف لا يظن الظان أنا نثبت القدم للحروف
والأصوات التي قامت بألسنتنا وصارت صفات لنا فإنا على قطع نعلم افتتاحها
واختتامها وتعلقها بأكسابنا وأفعالنا وقد بذلت السلف أرواحهم وصبروا على
أنواع البلايا والمحن من معتزلة الزمان دون أن يقولوا القرآن مخلوق ولم
يكن ذلك على حروف وأصوات هي أفعالنا وأكسابنا بل هم عرفوا يقيناً أن لله
تعالى قولاً وكلاماً وأمراً وإن أمره غير خلقه بل هو أزلي قديم بقدمه كما
ورد ذلك وفي قوله " ألا له الخلق والأمر " وقوله " لله الأمر من قبل ومن
بعد " وفي قوله سبحانه " إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون
" فالكائنات كلها إنما تتكون بقوله وأمره وقوله إنما أمره إذا أراد شيئاً
أن يقول له كن فيكون وقوله وإذ قال ربك وإذ قلنا قال الله هذا كله قول قد
ورد في السمع مضافاً إلى الله تعالى أخص إضافة من الخلق فإن المخلوق لا
ينسب إلى الله تعالى إلا من جهة واحدة وهو الخلق والإبداع والأمر بنسب
إليه لا على تلك النسبة وإلا فيرتفع الفرق بين الأمر والخلق والخلقيات
والأمريات.
قالوا من جهة المعقول العاقل يجد من نفسه فرقاً ضرورياً بين
قال وفعل وبين أمر وخلق ولو كان القول فعلاً كسائر الأفعال بطل الفرق
الضروري فثبت أن القول غير الفعل وهو قبل الفعل وقبليته قلية أزلية إذ لو
كان له أول لكان فعلاً سبقه قول آخر ويتسلسل ثم لما أجمعت السلف على أن
هذا القرآن هو كلام الله تعالى لم يرد مناهج إجماعهم ولم يبحث أنهم أرادوا
القراءة أو المقروء والكتابة أو المكتوب كما أنهم إذا وصلوا إلى تربة
الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيوا
وصلوا وسلموا تسليماً من غير تصرف في أن المشار إليه شخصه أم روحه.
وحققوا
زيادة تحقيق فقالوا قد ورد في التنزيل أظهر مما ذكرناه من الأمر وهو
التعرض لإثبات كلمات الله تعالى حيث قال عز من قائل " وتمت كلمات ربك
صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته " ثم قال " ولولا كلمة سبقت من ربك " وقال "
قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي " وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة
أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله " وقال " ولكن حق
القول مني لأملأن جهنم وكذلك حقت كلمة العذاب " فتارة يجي الكلام بلفظ
الأمر وتثبت له الوحدة الخالصية التي لا كثرة فيها " وما أمرنا إلا واحدة
كلمح بالبصر " وتارة يجي بلفظ الكلمات وتثبت لها الكثرة البالغة التي لا
وحدة فيها ولا نهاية لها " ما نفدت كلمات الله " فله إذاً أمر واحد وكلمات
كثيرة ولا يتصور إلا بحروف فعن هذا قلنا أمره قديم وكلماته كثيرة أزلية
والكلمات مظاهر الأمر للأمر والروحانيات مظاهر الكلمات والأجسام مظاهر
الروحانيات والإبداع والخلق إنما يبتدئ من الأرواح والأجسام أما الكلمات
والحروف فأزلية قديمة فكما أن أمره لا يشبه أمرنا وكلماته وحروفه لا تشبه
كلماتنا وهي حروف قدسية وعلوية وكما أن الحروف بسائط الكلمات والكلمات
أسباب الروحانيات والروحانيات مدبرات الجسمانيات وكل الكون قائم بكلمة
الله محفوظ بأمر الله تعالى ولا يغفل عاقل عن مذهب السلف وظهور القول في
حدوث الحروف فإن له شأناً وهم يسلمون الفرق بين القراءة والمقروء والكتابة
والمكتوب ويحكمون بأن القراءة التي هي صفتنا وفعلنا غير المقروء والذي ليس
هو صفة لنا ولا فعلنا غير أن المقروء بالقراءة قصص وأخبار وأحكام وأوامر
وليس المقروء من قصة آدم وإبليس هو بعينه المقروء من قصة موسى وفرعون وليس
أحكام الشرائع الماضية هي بعينها أحكام الشرائع الخاتمة فلا بد إذاً من
كلمات تصدر من كلمة وترد على كلمة ولا بد من حروف تتركب منها الكلمات وتلك
الحروف لا تشبه حروفنا وتلك الكلمات لا تشبه كلامنا كما ورد في حق موسى
عليه السلام سمع كلام الله كجر السلاسل وكما قال المصطفى صلوات الله عليه
في الوحي أحياناً يأتيني كصلصلة الجرس وهو أشد علي ثم يفصم عني وقد وعيت
ما قال والله أعلم.
القاعدة الرابعة عشرة
في حقيقة الكلام الإنساني والنطق النفساني
ذهب النظام إلى أن الكلام جسم لطيف منبعث من المتكلم ويقرع أجزاء الهوى فيتموج الهوى بحركته ويتشكل بشكله ثم يقرع العصب المفروش في الأذن فيتشكل العصب بشكله ثم يصل إلى الخيال فيعرض على الفكر العقلي فيفهم وربما يقول الكلام حركة في جسم لطيف على شكل مخصوص ثم تحير في أن الشكل إذا حدث في الهوى أهو شكل واحد يسمعه السامعون أم أشكال كثيرة وإنما أخذ مذهبه في هذه المسئلة وغيرها من المسائل من مذهب الفلاسفة غير أنه لم يفهم من كلامهم إلا ضجيجاً ولم يورده نضيجاً.وأما الفلاسفة فالنطق عندهم يطلق على نطق اللسان وهو
حروف منظومة بأصوات مقطعة في مخارج مخصوصة نظماً يعبر عن المعنى الذي في
النفس بحكم الاصطلاح والمواضعة أو بحكم التوقيف والمصادرة ويطلق النطق على
التمييز العقلي والتفكير النفساني والتصوير الخيالي وهو معان في ذهن
الإنسان مختلفة الاعتبار فإن اعتبرت بمجرد العقل كان تمييزاً صحيحاً بين
الحق والباطل ويلزمه أن يكون معاني كلية مجردة متحدة متفقة فإن اعتبرت
بمجرد النفس كان تفكيراً وترديداً بين الحق والباطل حتى يظفر بالحد الأوسط
فيطلع على الدليل المرشد والعلة والسبب ويلزمها أن تكون ذاتية كلية أو
جزئية بسيطة أو مركبة ويلزمها أن تكون ذاتية أو عرضية موجبة أو سالبة
موجهة أو مطلقة يقينية أو غير يقينية منتجة أو غير منتجة وإن اعتبرت بمجرد
الخيال كانت تقديراً أو تصويراً فتارة تصوير المحسوس بالمعقول وتارة تقدير
المعقول في المحسوس ويلزمها أن تكون من جانب المحسوس عربياً أو عجمياً أو
هندياً أو رومياً أو سريانياً أو عبرانياً ومن جانب المعقول أن يكون
بسيطاً في صورة مركبة ومركباً على نعت بسيط وذاتياً مع عرضي ويقيناً مع
وهم وأول ما يرد على السمع حرف وصوت يحصل في الهوى بسبب تموج يقع بحركة
شديدة تحدث من قرع بعنف أو قلع بحدة فإن كان من قرع اصطك الجسمان وانضغط
الهوى بشدة وحدث الصوت وإن كان من قلع انقطع الجسمان وانفلت الهوى بشدة
وحدث الصوت ووصل الموج إلى الهوى الراكد الذي في الصماخ وانفعل به وهو
مجاور للعصبة المفروشة في أقصى الصماخ الممدودة مد الجلد على الطبل فيحصل
فيه طنين فتشعر به القوة المودعة في تلك العصبة فيصل إلى القوة الخيالية
فيتصرف الخيال فيه تقديراً فيصل إلى القوة النفسانية فتتصرف النفس فيه
تفكيراً فيصل إلى القوة العقلية فيتصرف العقل فيه تمييزاً وللمعنى صعود من
المحسوس المسموع إلى المعقول المعلوم صعوداً من الكثرة إلى الوحدة ونزول
من المعقول المعلوم إلى المحسوس المسموع نزولاً من الوحدة إلى الكثرة
والعرفان مبتدئ من تفريق ونفض وترك ورفض ممعن في جمع هو جمع صفات الحق
للذات المريدة للصدق ثم انتهى إلى الوحدة ثم وقوف وهذا من حيث الصعود
والعرفان مبتدئ من توحيد وتفكير وتمييز وتصوير ممعن في معرفة هي معرفة
صفات الخلق ثم انتهى إلى الكثرة ثم وقوف وهذا من حيث النزول.
وصار أبو
الهذيل والشحام وأبو علي الجبائي إلى أن الكلام حروف مفيدة مسموعة من
الأصوات غير مسموعة مع الكتابة وصار الباقون من المعتزلة إلى أن الكلام
حروف منتظمة ضرباً من الانتظام والحروف أصوات مقطعة ضرباً من التقطيع وهل
يجوز وجود حروف من غير أصوات كما جاز وجود أصوات من غير حروف فيه خلاف
بينهم.
وصار أبو الحسن الأشعري إلى أن الكلام معنى قائم بالنفس
الإنسانية وبذات المتكلم وليس بحروف ولا أصوات وإنما هو القول الذي يجده
العاقل من نفسه ويجيله في خلده وفي تسمية الحروف التي في اللسان كلاماً
حقيقياً تردد أهو على سبيل الحقيقة أم على طريق المجاز وإن كان على طريق
الحقيقة فإطلاق اسم الكلام عليه وعلى النطق النفسي بالاشتراك.
قالت
الأشعرية العاقل إذا راجع نفسه وطالع ذهنه وجد من هيئة وجودها أو سمعها من
مبتدأها إلى منتهاها على وفق ثبوتها وتارة حديثاً مع نفسه بأمر ونهي ووعد
ووعيد لأشخاص على تقدير وجودهم ومشاهدتهم ثم يعبر عن تلك الأحاديث وقت
المشاهدة وتارة نطقاً عقلياً إما يجزم القول أن الحق والصدق كذا وإما
بترديد الفكر أنه هل يجوز أن يكون الشيء كذا أو يستحيل أو يجب إلى غير ذلك
من الأفكار حتى أن كل صانع يحدث مع نفسه أولاً بالغرض الذي توجهت إليه
صنعته ثم تنطق نفسه في حال الفعل محادثة مع الآلات والأدوات والمواد
والعناصر ومن أنكر أمثال هذه المعاني فقد جحد الضرورة وباهت العقل وأنكر
الأوائل التي في ذهن الإنسان وسبيله سبيل السوفسطائية كيف وإنكاره ذلك مما
لم يدر في قلبه ولا جال في ذهنه ثم لم يعبر عنه بالإنكار ولا أشار إليه
بالإقرار فوجد أن المعنى معلوم بالضرورة وإنما الشك في أنه هو العلم بنفسه
أو الإرادة والتقدير والتفكير والتصوير والتدبير والتمييز بينه وبين العلم
هين إذ العلم تبين محض تابع للمعلوم على ما هو به وليس فيه إخبار ولا
اقتضاء وطلب ولا استفهام ولا دعاء ولا نداء وعي أقسام معلومة وقضايا
معقولة وراء التبيين والتمييز بينه وبين الإرادة أسهل وأهون فإن الإرادة
قصد إلى تخصيص الفعل ببعض الجائزات ولا قصد في هذه القضايا ولا تخصيص وأما
التقدير والتفكير والتدبير فكل ذلك عبارات عن حديث النفس وهو الذي يعنى به
من النطق النفساني ومن العجب أن الإنسان يجوز أن يخلو ذهنه عن كل معنى ولا
يجد نفسه قط خالياً عن حديث النفس حتى في النوم فإنه في الحقيقة يرى في
منامه أشياء وتحدث نفسه بالأشياء ولربما يطاوعه لسانه وهو في منامه حتى
يتكلم وينطق متابعة لنفسه فيما يحدث وينطق.
ومن مذاهب المعتزلة أن
المفكر قبل ورود السمع يجد من نفسه خاطرين أحدهما يدعوه إلى معرفة الصانع
وشكر المنعم وسلوك سبيل المحاسن والخيرات والثاني يدعوه إلى خلاف ذلك ثم
يختار ما فيه النجاة ويجتنب عما فيه الهلاك وذلك الخاطران الداعيان
المحدثان المخبران عن كلام النفس وحديثها فكيف يسوغ لهم إنكار ذلك وأيضاً
فإن الإنسان في مراتب نظره واستدلاله يضع قولاً ويرفع قولاً ويقسم كلياً
ويبطل أحد القسمين فيتعين له الثاني فتقسيمه هو بعينه حديث النفس وتعيينه
أحد القسمين هو بعينه حكم العقل وربما أخذ القلم وكتب مجلدة من حديث فكره
وشحن ديواناً من حديث نفسه ولسانه ساكت لا ينطق.
وصدق من قال:
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا
فالعبارة
والإشارة والكتابة دلالة بقرائنها تدل على أن لها مدلولاً خاصاً متميزاً
عن العلم والإرادة ولكل عبارة خاصة مدلول خاص متميز عن سائر المدلولات
وهذا أوضح ما تقرر فإن دلالات العبارات على النطق دلالة المواضعة والتوقيف
ويختلف بالأمم والأمصار ودلالة الأحكام على العلم دلالة العقل فلا يختلف
ذلك بالأمم والأمصار ومدلول العبارات مع اختلافها مدلول واحد فإن المعنى
الذي يفهم من قولك الله هو بعينه المعنى الذي يفهم من خذ أي وتنكري وسرنا
وند إلى غير ذلك من الألفاظ فعلم من ذلك أن الكلام الذي في نفس الإنسان
قول محقق ونطق موجود هو أخص وصف لنفس الإنسان حتى تميز به عن سائر
الحيوانات ومن أنكره فقد خرج عن حد الإنسانية ودخل في حريم البهيمة وكفر
أخص نعم الله تعالى على نوع الإنسان.
قالت المعتزلة نحن لا ننكر
الخواطر التي تطرأ على قلب الإنسان وربما نسميها أحاديث النفس إما مجازاً
وإما حقيقة غير أنها تقديرات للعبارات التي في اللسان ألا ترى أن من لا
يعرف كلمة بالعربية لا يخطر بباله كلام العرب ومن لا يعرف العجمية لا يطرأ
عليه كلام العجم ومن عرف اللسانين تارة تحدث نفسه بلسان العرب وتارة بلسان
العجم فعلم على الحقيقة أنها تقديرات وأحاديث تابعة للعبارات التي تعلمها
الإنسان في أول نشوه والعبارات هي أصول لها منها تصدر وعليها ترد حتى لو
قدرنا إنساناً خالياً عن العبارات كلها أبكم لا يقدر على نطق لم نشك أن
نفسه لا تحدثه بعربية ولا عجمية ولا لسان من الألسن وعقله يعقل كل معقول
وإن كان يعرى عن كل مسموع ومنقول فعلم أن الكلام الحقيقي هو الحروف
المنظومة التي في اللسان والمتعارف من أهل اللغة والعقلاء أن الذي في
اللسان هو الكلام ومن قدر عليه فهو المتكلم ومن لم يقدر عليه فهو الأعجم
الأبكم فعلم من ذلك أن الكلام ليس جنساً ونوعاً في نفسه ذا حقيقة عقلية
كسائر المعاني بل هو مختلف بالمواضعة والاصطلاح والتواطؤ حتى لو تواطأ قوم
على نقرات وإشارات ورمزات لحصل التفاهم بها كما حصل التفاهم بالعبارات.
ومن
الدليل على ذلك أن الله تعالى سمى تغريد الطير وأصوات الحكل ودبيب النمل
كلاماً وقولاً حتى قال سليمان بن داود عليهما السلام " علمنا منطق الطير
وقالت نملة وقال الهدهد أحطت بما لم تحط به " ومثل ذلك يجري مجازاً في
الجمادات أيضاً " قالتا أتينا طائعين " " يا جبال أوبي معه والطير " "
يسبح الرعد بحمده " ويعبر عن أحوال دلالاتهم على وجود الصانع بالتسبيح
والتأويب وعن استعدادهم لقبول فعله وصنعه بالطوع والرغبة قولا وذلك كله
يدل على أن الكلام ليس نوعاً من الأعراض ذا حقيقة عقلية كسائر الأعراض بل
نطلقه على النطق الذي في اللسان بحكم المواضعة والمواطأة والإنسان قد يخلو
عنه وعن ضده وتبقى حقيقته إنسانيته فإنه إنما يتميز عن الحيوانات بصورته
وشكله لا بنفسه أو عقله ونطقه وقوله وأنتم يا معشر الأشاعرة انتهجتم مناهج
الفلاسفة حيث حددتم الكلام بالنطق النفسي كما حدوا الإنسان بقولهم الحيوان
الناطق وجعلوا النطق أخص وصف الإنسان تميز به عن سائر الحيوانات وجعلوه
الفصل الذاتي ويلزمكم على مساق ذلك أن تكون النفس الناطقة هي الإنسان من
حيث الحقيقة والبدن يكون آلة وقالباً لها ثم يلزم منه أن يكون الخطاب
والتكليف على النفس والروح دون البدن والجسد وأن يكون المعاد للأرواح
والنفوس والثواب والعقاب لها وعليها وذلك طي لمسالك الشريعة وغي في مهالك
الطبيعة.
قالت الأشعرية الذي يشعر به نفس الإنسان معان مختلفة الحقائق
وراء التمييز العقلي والتصوير الخيالي فإن التمييز العقلي حكم جزم بأن
الأمر كذا وأن الحق في القضية كذا والتصوير الخيالي تقدير ما سمعه من
العبارة من العربية والعجمية كما ذكرتم وليس فيه حكم ونفي الأمر الأوسط
وهو التدبير النفساني الذي لا يعدمه كل ذي عقل ونفس من الإنسان سواء عدم
النطق اللساني أو لم يعدم.
ومن البرهان على ذلك سوى الإحساس الذي لا
ينكره إلا معاند جاحد أن كل عاقل مكلف بالنظر والاستدلال حتى يحصل لنفسه
المعرفة بوحدانية الصانع ولن يتأتى الفكر والنظر إلا بترديد الخاطرين في
جهات الإمكان وتدبير الأوائل التي هي بدائه العقل بالثواني والثوالث في
ترتيب المقدمات القياسية والتمييز فيها بين اليقيني والجدلي والخطابي
والشعري ثم التدرج من ذلك الترتيب المخصوص والشكل الموصوف المعين إلى
النتيجة التي هي المطلوبة وهذا التردد لن يتأتى إلا بأقوال عقلية ونطق
نفساني يكون اللسان معبراً عنها تارة بالعربية وتارة بالعجمية إن كان
منطقياً وبالإشارة والإيماء إن كان أيكم فعلم من ذلك أن الذي حصل في
الخيال غير والذي حصل في النفس غير وأن الذي حصل في العقل غير ومن أمكنه
التمييز بين هذه الاعتبارات سهل عليه تقدير النطق النفساني والقول بأن ذلك
المعنى جنس ونوع من المعاني له حقيقة لا تختلف والذي في الخيال واللسان
ليس جنساً ونوعاً حقيقياً ثابتاً بل يختلف ذلك بحسب الاصطلاح والمواضعة
وعلى إمكان التعبير من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص ومكان إلى مكان وذلك
ليس كلاماً حقيقياً ولا نوعاً متنوعاً ويتبعه الذي في الخيال من الصور
والأشكال عن الحروف والكلمات التي في السمع وعن المبصرات والمدركات التي
في البصر لكن المعاني التي في النفس حقائق موجودة تتردد فيها النفس بنطقها
الذاتي وتمييزها العقلي وهذا لا ينكره إلا من أنكر نفسه وعدم حديثه وحسه.
وقولهم يجوز أن يحصل التفاهم بالنقرات والرمزات كما يحصل بالعبارات.
قلنا
وهذا من الدليل القاطع على أن الذي في اللسان كلام مجازي فإن التفاهم حاصل
بغيره والفهم نطق نفساني دون العلم العقلي فإن الإنسان يجوز أن يفهم
باطلاً وينكره بعقله فالفهم غير ذلك فالفهم غير والعلم غير وذلك الفهم
مدلول كلام القائل فقط وهو نطق مجرد نفساني ومحاورة فكرية إذ يديره في
خلده فيجيب عنه تسليماً له واعتراضاً عليه وربما يكون معنى في الذهن يبسط
ويشرح في العبارة وربما يكون معاني كثيرة تقبض وتختصر في اللفظ وبالجملة
مدلولات العبارات والإشارات نطق نفساني بخلاف مدلولات أصوات البهائم
وتغريد الطير فإنها وإن حصل بها التفاهم الخيالي فلم يحصل بها الفهم
النفساني حتى تتصرف فيما سمعته بالكلية والجزئية والموجبة والسالبة
والذاتية والعرضية فقد عدمت تلك النفوس ما هو من خواص النفس الإنسانية
وعدمت أيضاً ما هو من خواص العقل الإنساني من الاعتبارات الكلية التي له
والأحكام الجزئية التي إليه وبالجملة فهي عادمة الكليات واجدة الجزئيات
فلم تكن أصواتهم وألحانهم قولاً ونطقاً وما ورد في التنزيل من نسبة الكلام
إلى أمثالهم فهو محمول على أحد وجهين أحدهما أنه أعطاهم عقلاً وأنطقهم
حقيقة بحرف وصوت وجعل ذلك معجزة لذلك النبي الذي هو في زمانه والثاني أنه
أجرى على لسانهم وهم لا يعرفون كلاماً ففهمه نبي ذلك الزمان من غير أن
يشعر به المتكلم من الوحش والطير كما أجرى على ذراع الشاة لا تأكل مني
فإني مسمومة.
وأما نسبة صاحب هذه المقالة إلى الفلاسفة والتشنيع عليه
بأنه يودي إلى كون النفس جوهراً روحانياً غير جسم وإن الخطاب يتوجه عليه
وإن الثواب والعقاب له فهو سؤال لا يستحق الجواب والمعاني العقلية إذا
لاحت حسية كالشمس وجب اعتقادها ولزم اعتقالها من غير التفات إلى مذهب دون
مذهب وقد قالت الفلاسفة النفس الإنساني عندنا بالمعنى الذي يشترك فيه
الإنسان والحيوان والنبات أنه كمال أول لجسم طبيعي متحرك آلي ذي حياة
بالقوة وبالمعنى الذي يشترك فيه الإنسان والملك أنه جوهر غير جسم هو كمال
أول لجسم طبيعي محرك له بالاختيار عن مبدأ نطقي عقلي بالفعل وبالقوة فالذي
بالفعل هو خاصة النفس الملكية والذي بالقوة هو فصل النفس الإنساني فالنطق
فصل ذاتي على كل حال سواء كان بالقوة والاستعداد أو كان بالفعل والوجود
ومن عدم المعنيين كان فصله الذاتي عجمة إما صاهل أو ناطق أو هادر أو فصل
آخر.
قالوا ولا بد من إثبات النفس وإثبات جوهريته أولاً حتى يصح
إثبات النطق العقلي له ثانياً والأشعري إن وافق المعتزلة على أن نفي الروح
والنفس جوهراً بلا عرض لا يبقى زمانيين وهو الحياة فقط فهو كالمعتزلي إذا
وافق الطبيعي منا على أن النفس ليس جوهراً روحانياً لا يقبل الاستحالة بل
هو جسم قابل للكون والفساد وعرض تابع للمزاج ولا فرق بين قولهم مستحيل أي
متغير حالاً فحالاً وبين قولهم لا يبقى زمانين أي موجود حالاً فحالاً.
وأما
الفلاسفة الإلهيون فقد دلوا على وجود النفس من جهة إدراكها ومن جهة
أحوالها أما الأفعال فأخص أفعالها بعد خروجها عن حد الاستعداد والانفعال
التردد بين القضايا العقلية طلباً للدليل على المدلول وعثوراً على العلة
المقتضية للوجود أعني وجود المطلوب أو الاعتقاد بالوجود حتى يرد الثواني
إلى الأوائل والثوالث إلى الثواني ويستدل بأمر خاص في ذهنه على أمر مستحضر
ويتوصل بمعنى حاصل إلى معنى مستحصل وذلك من أخص أفعال النفس الإنسانية ليس
لغيرها فيه نصيب وشركة ومن خواص أفعالها أنها إذا خرجت من القوة إلى الفعل
عقلاً وعلماً أو خلقاً وعملاً أخرجت غيره من النفوس الإنسانية من القوة
إلى الفعل حتى تصير صورتها مشابهة لصورة المخرج كالمعلم للقراءة يخرج نفس
الصبي من قوة الاستعداد إلى فعل القراءة حتى يصير قارئاً مثله وكالمعلم
للحكمة يخرج نفس المتعلم من قوة الصلاحية إلى فعل الحكمة حتى يصير حكيماً
مثله وكالمعلم للصناعات البشرية الخاصة بنوع الإنسان يخرج نفوس المتعلمين
من القوة إلى الفعل حتى يصير صانعاً مثله وليست هذه الخاصية أيضاً لنوع من
الحيوانات لأن ما لها بالطبع والفطرة فهي لمواليدها كذلك فهذا المعنى
فضيلة النفس الإنسانية وانفصلت وإليه الإشارة بقوله تعالى " وعلم آدم
الأسماء كلها " الآية وكان له قوة القبول وقوة الأداء في طرفي العلم
والعمل ومن خواص أفعالها أنها حيثما كثرت أفعالها ازدادت قوة وكمالاً
وغيرها من النفوس والأجسام وقواها الجسمانية حيثما كثرت أفعالها ازدادت
ضعفاً وكلالاً.
ومن خواص قواها وأفعالها أن كل قوة جسمانية فهي متناهية
الأثر إلى حد معلوم والقوة على ما لا يتناهى لا يتصور في الجسم بخلاف
القوة العقلية النفسانية فإنها تقوى على ما لا يتناهى إذ ما يمكن أن تدركه
النفس الناطقة من المحسوسات والمعقولات ليست محصورة فيستحيل أن يكون ذاتها
ذاتاً جسمانياً وقواها قوى جسمانية.
وأما خواصها من جهة إدراكها فأخص
إدراكاتها أنها تدرك ذاتها بذاتها وأن ذاتها لا تعزب عن ذاتها وتراها تغفل
عن كل شيء تقديراً سوى ذاتها حتى النائم والسكران يغفل عن كل شيء سوى ذاته
ثم المدرك من ذاته ليس بآلة جسمانية أو نفسانية لأنا فرضناها غافلة عن كل
شيء سوى ذاتها والمدرك ليس جسماً أو جزءاً من جسم فإنا في الفرض المذكور
أغفلناها عن كل شيء سوى ذاتها فهي مدرِكة ومدرَكة وعاقلة ومعقولة لا
يحجبها عن ذاتها شيء البتة ونفس إدراكها نفسها لا كالحواس فإنها لا تدرك
ذاتها بذاتها ولا كالمدرك بالآلات إذا أصابت الآلة آفة بطل إدراكه أو ضعف
ولا كالمدرك بآلة إذا أدرك شيئاً قوياً لم يمكنه إدراك الضعيف بل هي تدرك
الضعيف بعد القوي والخفي بعد الجلي ولا كما يضعف بامتداد الزمان ويبليه
ممر الدهور والحدثان فإنه ربما يقوى في الكبير ويضعف في الصغير فهذه كلها
من خواص النفس الإنسانية نحس من أنفسنا ضرورة أن الأمر كذلك من غير احتياج
إلى برهان يقام عليه والمعاني الضرورية إذا احتال المرء فيها لطلب برهان
عليها ازدادت خفاءً وانتقصت جلاءً.
ثم البرهان القاطع على أن النفس ليس
بجسم ولا قوة في جسم أن العلم المجرد الكلي لا يجوز أن يحل في جسم وكل ما
لا يجوز أن يحل في جسم فإذا حل حل في غير جسم فالعلم المجرد الكلي إذا حل
حل في غير جسم.
أما المقدمة فنثبتها بناءً على أن كل جسم منقسم وما حل في منقسم يجب أن يكون منقسماً ونثبتها بناءً على أن كل جسم فمركب من مادة وصورة والمعنى الوحداني الكلي بالذات لا يحل في مركب ونثبتها بناءً على أن كل جسم فهو ذو وضع وقدر وشكل وحيز وكل ما حل في ذي قدر ووضع فيكون له نسبة وقدر وهيئة ووضع والمعنى المعقول المجرد في نفس الإنسان مجرد عن القدر والوضع فتجرده إما أن يكون باعتبار محله أو باعتبار ما منه حصل وباطل أن يكون تجرده بما منه حصل فإن الإنسان يتلقى حد الإنسان وحقيقته من إنسان شخصي له قدر مخصوص لكن الحس تجرده نوع تجريد عن المادة فإن المادة لا تدخل في الحس بل التماثل الذي يطابقه يرتسم فيه والخيال يجرده تجريداً أشد فإن الحس يناله وهو حاضر والخيال يناله وهو غائب والفكر يجرده تجريداً أشد فإن الخيال يناله مع غبوبيته شخصياً جزئياً والفكر العقلي يتصوره مجرداً فيتصوره العقل كلياً واحداً مبرأ من الوضع والقدر مجرداً عن المادة والشكل فتجرده بما هو مجرد وتفرده عن العلائق المادية بما هو مفرد فدل إدراكه المعقول على هذا الوجه المذكور على أن ذات النفس الناطقة العاقلة لا تنقسم إلى جزء وجزء ولا تتركب من مادة وصورة ولا توصف بوضع ومقدار وشكل وحيز وذلك ما أردنا بيانه.
وأما امتياز النفس الإنسانية عن الأجسام
وقواها وسائر النفوس المزاجية من جهة حالاتها فإحدى حالاتها وهي على مراتب
فمنها حركاتها من قوة الاستعداد العلمي والعملي إلى الكمال ولما لم تكن
هيولى عقلها الهيولاني على مثل هيولى سائر الأجسام لم تكن حركاتها من
القوة إلى الفعل على مثل تلك الحركات بل أولى صورة لبستها الهيولى
الجسمانية هي الأبعاد الثلاثة من الطول والعرض والعمق وأولى صورة لبستها
الهيولى النفسانية هي الأحوال الثلاثة من العقل المستفاد والعقل بالملكة
والعقل بالفعل على ترتيب الأول والثاني والثالث وإنما يتصور ذلك الترتيب
إذا كان ثم تحرك من مبدأ إلى كمال وإنما تتصور الحركة حيث يتحقق ثم زمان
وهاهنا للنفس حالة أخرى غير زمانية وراء الأحوال الثلاثة وهي حالة المنام
فإنك لا تشك في نفسك أنك ترى في المنام الصادق أحوالاً كثيرة من حضورك في
قصورك وترددك بين رباع وديار وتقلبك بين أشجار وجنات وأنهار ومكالمتك
كلاماً كثيراً من سؤال وجواب وخبر واستخبار وقصة طويلة لو عبرت عنها في
اليقظة لوسعتها أوراق وضاق عن بسطها بيان وبنان وكل ذلك في لحظة واحدة
كأنها طرفة عين وكما غفوت رأيت جملة من ذلك ثم يعبر عنها بعبارات كثيرة
وربما يظن أن مثاله مثال انطباع صورة في المرآة في لحظة وهذا إن صدق
مثالاً في الصورة المبصرة فكيف يصدق في الكلام الكثير من السؤال والجواب
فإنها لا تنطبع معاً في المرآة إذ لا بد من تعاقب حروف ولا بد للتعاقب من
أزمنة متتالية حتى تدركها النفس وقد يرى الرائي في المنام أنه ختم القرآن
ويذكر انتقالات ذهنه من سورة إلى سورة ومن آية إلى آية كل ذلك خطرة ولحظة
فيعلم من ذلك ضرورة أن المدرك لذلك لو كان جسماً أو قوة في جسم لاستدعى
محلاً لهذه الإدراكات تتعاقب عليه المعاني والصور وتتتالى عليه الآيات
والسور ويستدعي ذلك التعاقب زماناً وأوقاتاً وتقدماً وتأخراً فاطلع من ذلك
على أن النفس ليست من جنس الأجسام والأجرام فإن إدراكاتها التي لها بالذات
ليست من جنس الإدراكات الحسية بالآلات الجسمانية وأنها فوق المكان والزمان
جوهراً وإدراكاً وليست هذه الحالة مخصوصة بالمنام بل وفي حالة اليقظة لها
ثلاثة أحوال أحدها أن يرتسم فيها صورة المعلومات مفصلة مسئلة مسئلة
والثانية أن ترتسم فيها جملة غير مفصلة لكن يحصل لها قوة وهيئة تقوى بها
على تلك المسائل والثالثة أن يحصل لها من العقل بالفعل والملكة في الفعل
أنه إذا سمع كلاماً في المناظرة مشتملاً على شبهة وقع في خاطره جواب ذلك
في أوحى ما يقدر وأسرع ما ينتظر كأنه معنى واحد ثم يعبر عنه بعبارات كثيرة
ويبسطه بسطاً واسعاً يشمل أوراقاً ويملأ أسماعاً فتحدس من ذلك أن النفس
الإنسانية لو كانت من جملة الأجسام لما كان حالها كما وصفنا ولو كانت من
عداد سائر النفوس الحيوانية المزاجية لما كان إدراكها إدراكاً غير زماني
وحال اليقظة فيما ذكرنا بحال الأنبياء أشبه وحال المنام بحال الأولياء
أقرب فقد تبين مما ذكرنا أن النفس الإنسانية ليست من شبح الأجسام التي
تتناهى بالحدود وتنقسم بالقسم وإن النطق الذي لها ليس من جملة النطق
اللساني الذي يختلف بالأمصار والأمم وأنها هي الأصل في الإنسانية
والمخاطبة بالأحكام التكليفية.
اعترض عليهم معترض من وجوه ثلاثة أحدها
اعتراض على الحدود والرسم الذي ذكروه والثاني اعتراض على خواص أفعالها
والثالث اعتراض على إدراكاتها وأحوالها وردها إلى مدرك آخر.
أما
الأول فقولهم حد النفس بالمعنى الذي يشاركه النفس الحيوانية والنباتية أنه
كمال جسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة قيل أولاً ما المعنى بالكمال الذي
ذكرتموه أهو جزء من جسم أم عرض في جسم أم أمر آخر وراء الجسم فإنكم ذكرتم
أنها بالمعنى الذي يشترك فيه الإنسان والملك وهو جوهر وراء الجسم والكمال
الذي وضعتموه موضع الجنس لفظ مشترك قد أطلق تارة بمعنى جزء وقوة أو عرض
وأطلق تارة بمعنى آخر هو وراء الجسم فمن الوجه الذي يشاركه الحيوان
والنبات لم يشاركه الملك ومن الوجه الذي يشاركه الملك لم يشاركه الحيوان
ولفظ الكمال واحد وقد أطلق إطلاق الجنس لا بالتواطؤ بل بالاشتراك على أن
الكمال من وجه آخر لفظ مشترك فإنه يطلق على المعنى الذي يقابله القوة
ويعنى به الفعل والوجود ويطلق على المعنى الذي يقابله المبدأ ويعنى به
الغاية والتمام ويطلق على المعنى الذي يقابله النقص والعيب ويعنى به
السلامة والألفاظ المشتركة لا تصلح ولا تستعمل في الحدود والرسوم ثم قلتم
كمال جسم فقد أضفتموه إلى الجسم أما إضافة على سبيل اللام وأما إضافة على
سبيل من وكمال الشيء ينبغي أن لا ينفصل عن الشيء فإنه إن انفصل عنه بجوهر
لم يكن كمالاً له فالنفس إذاً مكمل الجسم الطبيعي لا كمال له ثم النفوس
بجواهرها تنقسم على رأي إلى خيرة بالذات والجوهر وإلى شريرة بالذات
والجوهر فالتي هي خيرة كمالات ومكملات للأجسام الطبيعية الآلية حتى
تستعملها في جهات الخير فكيف يسوغ لنا أن نحكم بأن الشريرة كمالات ومكملات
للأجسام الطبيعية الآلية حتى تستعملها في جهات الشر فإن الأمر يتناقض فيه
وإطلاق لفظ الكمال هاهنا سمج.
وأما الاعتراض الثاني على خواص الأفعال
التي ذكروها هو أنا نسلم كلما قرروه ولكنا نقول بم تنكرون على من رد ذلك
كله إلى كمالية التركيب في المزاج وخاصية التأليف الواقع بين الأمشاج إذ
عرف من خواص الجوهر غرائب أفعال وعجائب أحوال لا يرتقي إليها الوهم ولا
يرتمي نحوها العقل والفهم من تسكين وتحريك وحل وعقد وتنمية وأذبال وجذب
وإرسال وتشخير وتدبير وحب وبغض وتصحيح وإمراض وإحياء وإماتة ما يقضي منه
العجب ألا ترى من خواص الأحجار وخواص النبات والأشجار وهدايات الحيوانات
إلى مصالحها ما لا يقصر في الدرجة عن خواص النفس الإنسانية ألا تعتبر من
تأليفات الأعداد المجردة عن المادة مثل أعداد الوفق وغيرها كيف يؤثر في
الأجسام حتى قيل أن النفس الإنسانية عدد تأليفي كل ذلك من كمالية التأليف
والتركيب وكما أن الأجرام البسيطة بما هيأتها ذوات خواص كذلك المركبات
بتأليفها ذوات خواص فبتأليف أكمل ترتقي المعادن والنبات على العناصر
وبتأليف أفضل يرتقي الحيوان والإنسان على المعادن والنبات فما دليلكم أن
هاهنا سوى التأليف الأفضل والتركيب الأكمل نفساً روحانية فإن جميع الخواص
التي عددتموها يمكن حملها على كمالية التركيب فقط سوى شيء واحد وهو إدراكه
للكليات والأمور التي لها وحدانية بالذات حيث يلزم انقسامها بانقسام المحل
وذلك هو المحال.
الاعتراض الثالث فنقول أولاً أنتم مطالبون بأن كل
عرض حل في محل انقسم بانقسام المحل ضرورة فإن هذه القضية عندنا ليست
ضرورية بل لما توهم في الألوان والأشكال أنها تنقسم بانقسام المحل أجري
حكم ذلك في الكل فمن الأعراض ما ينعدم بانقسام المحال كالمماسة والتأليف
ومنها ما لا ينعدم فيقوم بجزء منه قيامه بالكل وعند المتكلم العلم الواحد
لا يقوم إلا بجزء واحد وانعكس الأمر عليكم فنقول إن كان انقسام المحل يوجب
انقسام العرض فاتحاد العرض يستدعي اتحاد المحل وأنتم إذا سلمتم معنى
وحداني الذات لا ينقسم بوجه فيلزمكم أن تثبتوا محلاً له وحداني الذات لا
ينقسم أليست النقطة عرض وهو شيء ما لا ينقسم بوجوه فيلزمكم أن تثبتوا
محلاً له وحداني الذات لا ينقسم من الجسم ومحلها من الجسم وجب أن لا ينقسم
على أنا نلزمهم أمراً لا جواب لهم عنه وهو أن هذا المعنى الكلي الواحد
الذي يدركه العقل أيبقى مع العقل محفوظاً مذكوراً بالفعل أبد الدهر أو
يجوز أن يغفل عنه العقل ولا حاصل للقسم الأول فإن الإنسان يجد من نفسه
غفلته عن المعقولات المحصلة فيبقى متحفظاً في خزانة الحفظ وهي قوى جسمانية
إن جاز أن يحفظها كلية فلم لا يجوز أن يكون قوة جسمانية يحصلها كلية فإن
حفظ المرتسم في النفس كنفس الارتسام أم تبقى محفوظة في غير خزانة الحفظ
وهو العقل المفارق الفياض عليه كما قيل أنه يصير له كالخزانة الحافظة متى
طالعه أشرف عليه ثانياً وأفاده الصورة الأولة بعينها فيذكره ما قد نسي
ويذكر ثانياً ما قد أغفل فيلزم على مقتضى ذلك إشكالان أحدهما أن الصورة
المفصلة كيف ترتسخ في ذات واهب الصور مفصلة حتى تكون لزيد عنده صورة
ولعمرو صورة وهو يحفظ الكل مفصلاً منقسماً متعدداً متمايزاً بعضها عن بعض
بالكم والكيف وهو أحدي الذات واسع الإفاضة عام الإضافة وهذا من أمحل
المحال والإشكال الثاني أن الذي تصورتم في جانب الحفظ فيتصور في جانب
الإدراك الأول حتى تحكموا بأن المدرك للكليات هو العقل الفعال كما أن
الحافظ هو وليس إلى النفس الإنسانية إلا تركيب القضايا وتأليف المقدمات
ورفع الحجب ثم يكون العقل مدركاً كما كان حافظاً والإنسان يكون مدركاً
بإدراك في ذات العقل الفعال كما كان حافظاً بحفظ في ذات العقل الفعال
فيكون العقل الانفعالي حاصلاً له كما كان العقل الفعلي حاصلاً منه وتكون
نسبة العقول الجزئية إليه في العرض عليه نسبة الحواس الباطنة إلى العقل
الإنساني في العرض عليه وهذا موضع إشكال وشك عظيم وربما يستوفي شرحه في
المباحثات التي بيننا وبين الفلاسفة إن شاء الله.
القاعدة الخامسة عشر
في العلم بكون الباري تعالى سميعاً بصيراًذهب أبو القاسم الكعبي ومن تابعه من البغداديين إلى أن معنى كونه سميعاً بصيراً أنه عالم بالمسموعات والمبصرات لا زائد على كونه عالماً بالمعلومات ووافقه جماعة من النجارية ومن قال من المعتزلة أنه سميع بصير لذاته فمذهبه مذهب الكعبي لا غير ومن قال منهم أن المعنى بكونه سميعاً بصيراً أنه حي لا آفة به فمذهبه بخلاف مذهب الكعبي وهو الذي صار إليه الجبائي وابنه ومنهم من صار إلى أن معنى كونه سميعاً بصيراً أنه مدرك للمسموعات والمبصرات وذلك زائد على كونه عالماً.
وذهب أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أنه تعالى سميع بسمع بصير ببصر وهما صفتان قائمتان بذاته زائدتان على كونه عالماً.
ودليله في ذلك أن الحي إذا قبل معنى وله ضد ولا واسطة بين الضدين لم يخل عنه أو عن ضده فلو لم يتصف بكونه سميعاً بصيراً لاتصف بضدهما وذلك آفة ونقص وهذه المقدمات تحتاج إلى إثبات فلا بد من البرهان على كل واحدة منهما.
أما المقدمة الأولى فالدليل عليها أن المصحح لقبول السمع والبصر شاهداً هو كون الإنسان حياً إنا عرفنا ذلك بطريق السبر إذ لو كان المصحح وجوده أو حدوثه أو قيامه بالنفس أو غير ذلك من الأوصاف كان منتقضاً على الفور فبقي كونه حياً والباري تعالى حي فلزم القضاء بكونه موصوفاً بالسمع والبصر لتعاليه عن قبول الآفات والنقائص وليس منكر صحة قبول السمع والبصر أسعد حالاً ممن يزعم أن الباري تعالى لا يتصف بالعلم وضده مصيراً إلى استحالة اتصافه بحكميهما.
فإن قيل ما الدليل على أنه إذا لم يتصف بالسمع والبصر يجب أن يتصف بضدهما.
قيل كل ما دل على استحالة عرو الجوهر عن المتضادات فهو دليل على
ذلك وقد سبق القول فيه.
فإن قيل ما الدليل على أن الاتصاف بضد السمع والبصر من النقائص.
قيل
لما علم أن السمع والبصر من صفات المدح فذلك دليل على أن الاتصاف بأضداد
ذلك نقائص وآفات ويجب تعاليه عنها وقد وصف الرب تعالى نفسه بالسمع والبصر
على وجه التمدح كما وصف نفسه عالماً قادراً حياً على وجه التمدح فلولا
أنهما صفتا مدح لما تمدح بهما فيلزم أن يكون ضدهما صفتا ذم ونقص والنقص
دليل الحدوث ولو قدرنا الإدراك صفة زائدة على العلم أو قلنا أنه العلم ففي
نفيه نقص وقصور فلن يتحقق نقص إلا ممكناً محتاجاً إلى مكمل لتعود الذات
إلى الكمال وذات الباري تعالى وصفاته منزهة عن شوائب الإمكان ولا نقص في
ذاته وصفاته.
قال الكعبي إنما يصح لكم إثبات الإدراك غائباً بعد إثباته شاهداً ونحن لا
نساعدكم أن السمع والبصر إدراكان زائدان على العلم .
أما
الكعبي فقد قال الذي يجده الإنسان من نفسه إدراكه للمسموع والمبصر بقلبه
وعقله ولا يحس بصره بالمبصر بل يحس المبصر ويسمع السامع لا الأذان وذلك هو
العلم حقيقة ولكن لما لم يحصل له ذلك العلم إلا بوسائط بصره سمي البصر
حاسة وإلا فالمدرك هو العالم وإدراكه ليس زائداً على علمه.
والدليل على
ذلك أن من علم شيئاً بالخبر ثم رآه بالبصر وجد تفرقة بين الحالتين إلا أن
تلك التفرقة ليست تفرقة جنس وجنس ونوع ونوع بل تفرقة جملة وتفصيل وعموم
وخصوص وإطلاق وتعيين وإلا فشعور النفس بهما في الحالتين واحد.
قال ولو
كان المدرك مدركاً بإدراك للزم أن يحضر عند الحاسة السليمة قينة تلعب
وإنعام تسرح وطبول تضرب وصور تنفخ فيه وهو لا يراها ولا يسمعها إذ لم يخلق
له إدراك ذلك وكذلك يجوز أن يرى الشخص البعيد ولا يرى القريب لأنه خلق له
إدراك البعيد دون القريب وقد علمنا ضرورة أن الأمر على خلاف ذلك.
وقال الجبائي أن الحي إذا سلمت نفسه عن الآفة سمي سميعاً بصيراً ولا معنى
للإدراك شاهداً وغائباً إلا ذلك.
والدليل
عليه أن الذات إذا سلمت أدركت كل معروض عليها من المتماثلات والمختلفات
وإدراكها السواد كإدراكها البياض ولو كان مدركاً بإدراك لجاز أن يدرك بعض
الأشياء دون بعض مما يقابل المدرك فكان يجوز أن يدرك بياضاً ولا يدرك
سواداً وهما متقابلان للحاسة في حالة أو حالتين متعاقبتين كما أن العالم
منا جاز أن يعلم شيئاً دون شيء.
قالوا وإن سلمنا ثبوت الإدراك في
الشاهد فلم نسلم أن المصحح مجرد كون الحيوان حياً فقط وهاهنا شرط آخر وهو
حصول البنية وشرط للشرط وهو توسط الهوى المضيء بين المبصِر والمبصَر
والهوى الصافي بين السمع والمسموع كما شرطنا في الشم واللمس والذوق اتصال
الأجرام ومماستها بالاتفاق وإذا استدعت الثلاث من الحواس شرطاً حتى يتحقق
الإدراك ولأجل ذلك امتنع إثباته غائباً كذلك الحاستان الباقيتان استدعتا
شرائط أخر سوى كونه حياً حتى يتحقق الإدراك فأنتم مدفوعون إلى إقامة
الدليل على حصر الشرائط في كونه حياً فقط وإلا فارفعوا كون الحياة شرطاً
كما رفعتم كون البنية وتوسط الهوى شرطاً واجعلوا وجود الحياة شرطاً من حيث
العادة لا من حيث الضرورة كما جعلتم البنية شرطاً من حيث العادة وهذا
الموضع من مشكلات مسائل الإدراكات.
قال الأشعري الإدراكات من قبيل
العلوم على قول ورأي وهو جنس آخر على قول فمن قال بالقول الأول فيقول هو
مماثل للعلوم ولا يفترقان إلا في أن أحد العلمين يستدعي تعيين المدرك
والعلم من حيث هو علم لا يستدعي تعيين المدرك فلا جرم بقول العلم يتعلق
بالمعدوم والإدراك لا يتعلق به إذ المعدوم لا يتعين ولا تظنن أن هذا الرأي
هو مذهب الكعبي فإنه لم يثبت لإدراك معنى أصلاً والأشعري أثبت له معنى
وقال هو من جنس العلوم فعلى هذا القول الرب تعالى سميع بصير بإدراكين هما
علمان مخصوصان وراء كونه عالماً هو مدلول الأحكام والإتقان ومن قال بالقول
الثاني استدل بأن العلم بالشي إذا أضيف على علم آخر به واتحد المتعلق
واستوى العلمان في صفات النفس لم يتصور اختلافهما فلما وجدنا في أنفسنا
اختلافاً بين العلم والإدراك وأحسسنا تفرقة بين المعلوم خبراً وبين المرئي
عيان مع اتحاد المتعلق واستواء الأمر في الحدوث علمنا أن الجنسين مختلفان
وأيضاً فإن الأكمه لو أحاط علماً بما أحاط به البصير حصل له كل علم سوى
الإدراك فدل أنه زائد على العلم على أن هذا يشكل بقاعدة من لم يجعل البنية
شرطاً فإنه جوز أن يخلق الله تبارك وتعالى الروية في القلب والعلم في
البصر فحينئذ يلتبس العلم بالإدراك ويلزم أن يسمع السامع بالبصر ويبصر
بالسمع ويشم بحاسة الذوق ويذوق بحاسة الشم ويلزم أن تكون حاسة واحدة هي
سامعة مبصرة شامة ذائقة لامسة وإنما اختص كل إدراك بحاسة خاصة في خلقه
وكذلك يجوز أن تكون أمور حاضرة لا نحسها وأمور غائبة نبصرها ولكن العادة
الجارية أمنتنا من ذلك أليست الملائكة كانت تحضر مجلس النبوة والقوم حضور
والأعين سليمة وهم لا يبصرون أليست الشياطين والجن يطوفون في البلاد
ويسرحون في الأرض وإن إبليس هو يرانا وقبيله من حيث لا نراه فبطلت تلك
التهويلات والتشنيعات التي ألزمها الخصم.
وأما جواب الجبائي عن القاعدة
التي صار إليها من حد السميع والبصير أنه الحي الذي لا آفة به قيل أطلقت
القول بنفي الآفة وذلك بالاتفاق ليس بشرط فإن السميع والبصير قد يكون ذا
آفة وذا آفات كثيرة فلا بد وأن يخص نفي الآفة بمحل الإدراك ثم تلك الآفة
يجب أن تكون مانعة من الإدراك فقد أثبت الإدراك من حيث نفاه ثم الذي يحسه
الإنسان من نفسه معنى موجود لا نفي محض.
وقولهم لا آفة به نفي محض فلا
يتصور الإحساس به ويستحيل أن ترجع التفرقة بين حالتي الإدراك وعدم الإدراك
إلى عدم محض فحينئذ تنعدم التفرقة فإن التفرقة بالعدم وعدم التفرقة سوي.
ثم
نقول نحن نجد تفرقة ضرورية بين كون الإنسان سميعاً وبين كونه بصيراً وهما
متفقان في أن معنى كل واحد منهما أنه حي لا آفة به فهذه التفرقة ترجع إلى
ماذا فلا بد من أمرين زائدين على كونه حياً لا آفة به حتى يكون بأحدهما
سميعاً وبالثاني بصيراً وإلا فتبطل التفرقة الضرورية فالذي انفصل به السمع
عن البصر وهو وراء كونه حياً لا آفة به فكذلك الذي انفصل به السمع والبصر
عن العلم وسائر الصفات وراء كونه حياً لا آفة به ولئن ألزم الجبائي بأن
يقال معنى كونه عالماً قادراً أنه حي لا آفة به حتى يرد الصفات كلها إلى
كونه حياً لا آفة به لم يجد عن هذا الإلزام مخلصاً.
وقد قال بعض
العقلاء وقرر أن جميع صفات الكمال تجتمع في كونه حياً وتنتفي صفات النقص
بقولنا لا آفة به وأما اشتراطهم البنية حسب اشتراط الحياة غير صحيح فإن
الإدراك الواحد لا يقوم إلا بجزء واحد من الجملة وإذا قام به أفاد حكماً
له ولا أثر للجواهر المحيطة فإن كل جوهر مختص بحيزه موصوف بأعراضه وكما لا
يؤثر جوهر في جوهر لا يؤثر حكم جوهر في جوهر آخر ولا يختلف حكم جوهر بعينه
في تفرده وانضمامه وإذا جاز قيام الإدراك به مع اتصاله بالجواهر جاز قيامه
به مع تفرده فإنه لا يتحول عن صفته تفرد أو انضم إلى غيره خصوصاً إذا كان
الإدراك في صفة نفسه لا يقتضي جمعاً وإضافة ونسبة ولم يكن من الأعراض
الإضافية بخلاف الاجتماع والافتراق والمماسة ثم لو كانت البنية شركاً
كاشتراط كونه حياً لوجب طرده في الغائب حتى يكون الباري تعالى في علمه
وقدرته ذا بنية كما كان حياً لأن الشروط يجب طردها شاهداً وغائباً.
ومن
العجب أنهم كما شرطوا البنية شرطوا في الروية اتصال الأشعة وهي أجسام
مضيئة تنبعث عن البصر عند فتح الأجفان وهي أجسام تتشكل وتتحرك وتتعوج
وتستقيم فإذا اتصل الشعاع المنبعث من الناظر بالقاعدة على حد معلوم مع
الاستقامة ولم يكن ثم بعد مفرط ولا قرب مفرط أدركه الرائي فلذلك لا يرى
الشيء البعيد على غاية البعد ولا يرى باطن الأجفان وإن كانت القاعدة صقيلة
ارتدت الأشعة إلى الرائي فرأي عند ذلك نفسه وربما يظن أنه ينفصل عن
المتلون صورة ويمتد إلى العين فينطبع وكلا المذهبين باطل.
أما القول
بالأشعة التي تنبعث من العين فبطلانه بأنا نعلم قطعاً أن العين على صغرها
لا تتسع لأجسام تنبسط على نصف كرة العالم فإن تلك الأجسام إن كانت موجودة
بالفعل محسوسة بالجفن فوجب أن يكون قدرها مثل نصف قدر كرة السماء وهذا
محال وإن حدثت في ساعة الملاحظة فما السبب لحدوثها ومن المعلوم أن القدرة
الحادثة لا تصلح لحدوث الأجسام والقول بتولد الأجسام أمحل ويلزم من ذلك
أيضاً أن جماعة من ذوي الأبصار اجتمعوا على روية شيء وجب أن يقوى إدراك
الضعيف البصر الذي معهم فإن شعاعه إن قل ما في نفسه فقد تكثر بأشعتهم وإن
ضعف عن حالة القوى فقد يقوى باشتراك أشعتهم فينبغي أن يستعين الضعيف كما
يستعين بقوة ضوء السراج.
ثم الشعاع إن كان عرضاً فيستحيل عليه الانتقال
وإن كان جوهراً فلا يخلوا إما أن يبقى متصلاً وإما أن لا يبقى فإن بقي
فيلزم أن يتفرق ويدرك الشيء متفرقاً وينبغي أن يكون مثل خط مستقيم يتحرك
بتحريك الريح وينقطع بقطع الماء وإن لم يبق متصلاً فلم يدرك العين بما
اتصل به بل بما انفصل عنه فما اتصل بالمرئي لم يتصل بالعين وما اتصل
بالعين لم يتصل بالمرئي فيلزم أن لا يتحقق له إدراك أصلاً.
والقول
بانتقال صورة من المرئي إلى البصر باطل أيضاً فإن الصورة لو انتقلت
لاحترقت العين برؤية النار وهي إن كانت عرضاً فهي لا تنتقل وإن كانت
جوهراً فلينقص المرئي بانفصال شيء منه ولا ينفصل شيء منه إلا بسبب ولا سبب
هاهنا فهو باطل فتحقق أن الإدراك معنى في حاسة المدرك ثم يبقى هاهنا
مباحثة أخرى وهي أن الإدراك هل هو إدراك لصورة في حاسة المدرك تطابق
الصورة الخارجة أم هو إدراك ما في الخارج من غير توسط صورة في الحاسة وشيء
آخر وهو أن محل الإدراك هو الحاسة الظاهرة من العين والأنف والفم والأذن
أم هي آلات وأدوات للحاسة المشتركة بينهما فيكون الحس الحقيقي فيها حتى
تجتمع المختلفات فيها ويكون الإدراك إدراكاً واحداً فيظن بعض العقلاء أنه
هو العلم إذ هو في الباطن ويظن بعضهم أنه إدراك أخص من العلم إذ مدركه في
الظاهر والإدراكات الخمس مختلفة الحقائق حتى يكون اختلافها بالنوع أم
الاختلاف راجع إلى المدركات والإحساس بها بمعنى واحد وهذا الخلاف بين
المتكلمين والفلاسفة.
قال المتكلمون الحواس الخمس مشتملة على إدراكات
خمس تختلف أنواعها وحقائقها والإنسان يجد من نفسه أنه يرى ببصره ويسمع
بأذنه كما يجد أنه يعلم بقلبه فالبصر محل الرؤية والأذن محل السمع كالقلب
هو محل العلم وكما يجد التفرقة بين العلم والإدراك يجد التفرقة بين محل
العلم ومحل الإدراك ولأن الذي يدرك ببصره من المرئي هو الألوان والأشكال
فيستدعي ذلك مقابلة ومواجهة فالذي يدرك بسمعه من المسموع هو الأصوات
والحروف ولا يستدعي ذلك مقابلة وكذلك المشموم والمذوق والملموس يستدعي
اتصال الأجسام ولا يستدعيه السمع والبصر فلذلك يجوز أن يوصف الباري تعالى
بأنه سميع بصير ولا يجوز أن يوصف بأنه شام ذائق لامس وكذلك لا يجوز أن
يسمع الشيء من حيث يبصر ويبصر من حيث يسمع فدل ذلك على أن الإدراكات
مختلفة الحقائق والمحال جميعاً وهذا كله على رأي من يفرق بين الإدراك
والعلم فأما من قضى بأن الإدراك علم قضى باتحاد المحل والحقيقة.
سوى
أبي الحسن الأشعري فإنه يقول كل إدراك علم على قول ولا يقول كل علم إدراك
بل الإدراك علم مخصوص فإنه يستدعي تعيين المدرك ويتعلق بالموجود فقط
والوجود هو المصحح بخلاف العلم المطلق فإنه لا يستدعي تعيين المدرك ولا
يتعلق بالموجود من حيث هو موجود بل يتعلق بالمعدوم والموجود والواجب
والجائز والمستحيل لكن من الإدراكات ما هو علم مخصوص كالسمع والبصر وتردد
رأيه في سائر الإدراكات أهي علوم مخصوصة أم إدراكات ورأي بعض أصحابه أنها
إدراكات أخر وليس الوجود بمجرده مصححاً لها فقط بل الاتصال فيها شرط فلا
يتصور شم إلا باتصال أجزاء من المتروح أو من الهوى إلى المشام وكذلك الذوق
واللمس لا يتصور وجودهما إلا باتصال جرم بجرم.
وقالت الفلاسفة يرتسم في
الحواس الظاهرة بصور صورة تفيض عليها من واهب الصور عند استعدادات تحصل
فيها بمقابلة الحاس والمحسوس ثم قد تكون تلك الصورة نفس الإدراك وقد يكون
الإدراك شيء آخر دون تلك الصورة كمقابلة المرئي من الألوان والأشكال في
الرطوبة الجليدية من العين التي تشبه البرد والجمد فإنها مثل مرآة فإذا
قابلها متلون انطبع مثل صورته فيها كما ينطبع مثل صورة الإنسان في المرآة
بتوسط جسم شفاف بينهما لا بأن ينفصل من المتلون شيء ويمتد إلى العين ولا
بأن يتصل شعاع فيمتد إلى المتلون فإذا حصلت الصورة في الجليدية أفضت إلى
القوة الباصرة المودعة في ملتقى الأنبوبتين في مقدم الدماغ وهما عصبتان
مجوفتان على شكل صليب فتدركه النفس بهما فتكون الصورة في الجليدية من
العين والإدراك في الحس المشترك ولما كانت الجليدية كرية ومقابلة الكرة
يكون بالمركز وفرضنا سطحاً مستديراً مثلاً كالترس كان يقابله على خطوط
مستقيمة محيط بالترس متسع الأسفل متضايق الأعلى ينتهي إلى الجليدية على
دائرة صغيرة وحيثما ازداد الترس بعداً ضاقت الزاوية فصغر في العين فيرى
الكبير من البعد صغيراً فلو كان الإدراك معنى في العين وتعلق بالمدرك على
ما هو به كان المرئي مرئياً على مقدار شكله وصورته ولم يتفاوت الأمر
بالقرب والبعد وأيضاً فإن النقطة من النار إذا أديرت بسرعة أشبهت دائرة
يدركها البصر وهي في نفسها نقطة والقطر النازل يرى خطاً مستقيماً وهو
مستدير فتحقق أن الحس الحقيقي ما في الباطن دون الصورة الظاهرة وأما السمع
فإن الصوت والكلام المركب من الحروف إذا صادف الهوى الراكد الذي في الصماخ
المجاور للعصبة المفروشة في أقصى الصماخ الممدودة مد الجلد على الطبل
والوتر على الصنج حصل منه طنين فيها فتشعر به القوة المودعة في تلك العصبة
على رأي أو أدركه الحس المشترك على رأي فحصل السماع ثم الفهم ثم التمييز
ثم الحكم ثم القبول فتلك العصبة بالنسبة إلى الصوت والكلام نازل منزلة
الجليدية في العين غير أن الصورة في المرآة تحصل دفعة تامة والصورة في
العصبة تحصل متعاقبة في لحظة ويحصل الإدراك به وينتقش الخيال منه انتقاش
اللوح من القلم فيحصل فيه الكلام مكتوباً معايناً فيقرأ كما يقرأ من
الصحيفة وهاتان الحاستان ممتازتان عن سائر الحواس بأن إدراكهما غير ما
ارتسم في الحاستين وأما الشم فإنه بقوة في زائدتي الدماغ المشبهتين بحلمتي
الثدي وإنما يدرك بواسطة جسم ينفعل من الروائح وذلك بانفعال الهوى من ذي
الرائحة لا بانتقال أجزاء تنفصل منها أو رائحة تنتقل عنها فيصل إلى
الحلمتين فتدركه القوة المركوزة فيها والذوق هو قوة مودعة في العصبة
المفروشة على ظاهر اللسان بواسطة الرطوبة العذبة التي لا طعم لها المنبسطة
على ظاهر اللسان فإنها تأخذ طعم ذي الطعم وتستحيل إليه وتتصل بتلك العصبة
فتدركها العصبة واللمس هو قوة مبثوثة في جميع البشرة واللحم المتصل بها
يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والصلابة واللين والخشونة
والملاسة والخفة والثقل والذي يحمل هذه القوة جسم لطيف يجري في شباك العصب
ويستمد من القلب والدماغ وإنما يدرك إذا استحال كيفية البشرة إلى شبه
المدرك بشرط أن يتفاوتا في الكيفية وهذه القوى كلها معدات لقبول الفيض من
واهب الصور وإلا فالحاسة لا تحدث إدراكاً.
والأشعري فصل بين السمع
والبصر وبين الثلاثة الباقية حيث شرط هاهنا اتصالاً جسمانياً وأثبت
إحساساً جسمانياً ولم يثبتها في صفات الباري تعالى ولما علم أن لهما
اختصاصاً بالباطن ردد قوله في أن الإدراك علم مخصوص أو معنى آخر في الحاسة
المشتركة ولا يستبعد من مذهبه قيام الإدراك السمعي بالبصر والبصر بالسمع
فإن القوم حكموا باتحادهما عند الحاسة المشتركة حتى يصير المرئي مقروءاً
والمقروء مرئياً فإنهما في حقيقة الإدراك لا يختلفان ومحلهما محل واحد
فيتحدان وكلام المعتزلة في الإدراكات مختلط لا ثبات له والله أعلم.
القاعدة السادسة عشر
في جواز رؤية الباري تعالى عقلاً ووجوبها سمعاًلم يصر صائر من أهل القبلة إلى تجويز اتصال أشعة من البصر بذاته تعالى أو انطباع شبح يتمثل في الحاسة منه وانفصال شيء من الرائي والمرئي واتصاله بهما لكن أهل الأصول اختلفوا في أن الرؤية إدراك وراء العلم أم علم مخصوص ومن زعم أنه إدراك وراء العلم اختلف في اشتراط البنية واتصال الشعاع ونفي القرب المفرط والبعد المفرط وتوسط الهوى المشف فشرطها المعتزلة ونفوا رؤية الباري تعالى بالأبصار نفي الاستحالة والأشعري أثبتها إثبات الجواز على الإطلاق والوجوب بحكم الوعد ثم ردد قوله إنه علم مخصوص أي لا يتعلق إلا بالموجود أم هو إدراك حكمه حكم العلم في التعلق أي لا يتأثر من المرئي ولا يؤثر فيه ونحن نورد كلام الفريقين على الرسم المعهود.
قالت الأشعرية الموجودات اشتركت في قضايا واختلفت في قضايا والرؤية قد تعلقت بالمختلفات منها والمتفقات ولا يجوز أن يكون المصحح للرؤية ما يختلف فيه فإنه يوجب أن يكون لحكم واحد علتان مختلفتان وهذا غير جائز في المعقولات أو يلزم أن يكون لحكم عام علة خاصة هي أخص من معلولها وما يتفق فيه الجوهر والعرض إما الوجود أو الحدوث هو وجود مسبوق بعدم والعدم لا تأثير له في الحكم فبقي الوجود مصححاً بالضرورة وهذا تقسيم حاصر فإن الرؤية بالاتفاق تعلقت بالجوهر والعرض وهما قد اختلفا من كل وجه سوى الوجود والحدوث وقد بطل الحدوث فتعين الوجود ولا يلزم على هذه الطريقة انتشار الأقسام كما لزم على طريق الأصحاب غير استبعاد محض للمعتزلة في قولهم لو كان كل موجود مرئياً لكان العلم والقدرة والطعم والرائحة وما سوى اللون والمتلون مرئياً ولكان نفس الرؤية مرئية بالرؤية وهذا محال ويلتزم أبو الحسن جواز الرؤية في جميع الموجودات على الإطلاق خصوصاً إذا قال الرؤية علم مخصوص فالعلم كما يتعلق بهذه الموجودات كذلك الرؤية ولا فرق إلا أن العلم المطلق يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل وهذا العلم لا يتعلق إلا بالموجود فقط فإنه يقتضي تعيين المرئي والتعيين لا يتحقق في العدم وإن سلكنا طريقة العلم فهو أسهل فإن العلم من حيث هو علم نوع واحد وحقيقة واحدة وإذا جوز تعلق العلم به فقد جوز تعلق الرؤية به.
وقد سلك الأستاذ أبو إسحاق طريقة قريبة من هذه فقال الرؤية معنى لا تؤثر في المرئي ولا تتأثر منه فإن حكمه حكم العلم بخلاف سائر الحواس فإنها تؤثر وتتأثر وإنما يلزم الاستحالة فيه أن لو تأثرت الرؤية من المرئي أو تأثر المرئي من الرؤية وكل ما هذا سبيله فهو جائز التعلق بالقديم والحادث وكل مؤثر ومتأثر فهو مستحيل عندنا كما هو مستحيل عندكم ولا كلفة في هذه الطريقة إلا إثبات معنى في البصر لا يؤثر ولا يتأثر وقد أثبتنا من قبل أن الإدراك البصري لا يستدعي اتصال شعاع بالمرئي ولا انفصال شيء من الرائي وإذا بطل الوجهان انتفى التأثير والتأثر وصار المعنى كالعلم أو هو من جنس العلم وقد تقرر الاتفاق على جواز تعلق العلم به وهذا نهاية ما قيل في إثبات الجواز من جهة العقل.
قالت
المعتزلة قد طلبتم للرؤية علة مصححة وتعين لكم الوجود فما أنكرتم أن جواز
الرؤية من الأحكام التي لا تعلل فإن من الأحكام ما يعلل كالعالمية
والقادرية ومنها ما لا يعلل كالتحيز وقبول العرض وجميع الصفات النفسية
أليس تعلق العلم بالمعلومات لا يستدعي مصححاً إذ تعلق بالواجب والجائز
والمستحيل ولم توجد قضية هي أعم من الأقسام الثلاثة حتى تكون تلك القضية
هي المصححة لتعلق العلم بها وكونها معلومة هي نفس تعلق العلم بها فتكون
العلة والمعلول واحداً وإذا قررتم أن الرؤية إما علم مخصوص أو معنى في حكم
العلم ثم لم تطلبوا مصححاً للعلم فلم طلبتم مصححاً للرؤية فقولوا تعلقت
الرؤية بما تعلق به العلم أو لا علة ولا مصحح.
واعتراض ثان أن تقسيم
الحال إلى قضية الاشتراك والافتراق إنما يصح على مذهب مثبتي الحال وأنتم
معاشر الأشعرية قد نفيتم الحال ورددتم قضايا الخصوص والعموم والافتراق
والاشتراك إلى محض العبارات فكيف صرتم إلى إلزام أحكام الحال حتى أبطلتم
قضية الافتراق وعينتم قضية الاشتراك ثم حصرتم ذلك في قضية واحدة وهو
الوجود على أن الموجودات إنما تختلف بوجودها عندكم والوجود في الجوهر هو
نفس الجوهر وكما يتمايز الجوهر والعرض بالجوهرية والعرضية تمايزاً في
الوجود وكما تمايز القديم والحادث في القدم والحدوث تمايزاً في الوجود فإن
الوجود العام الذي شمل الموجودات حتى يصح أن يكون مصححاً وحتى يصح الجمع
بين الشاهد والغائب بذلك الجامع.
واعتراض ثالث قد أجملتم القول إجمالاً
في أن الرؤية تعلقت بالجوهر والعرض أما الجوهر المجرد والجسم المجرد فغير
مسلم تعلق الرؤية به إذ قد استحال تجرده عن اللون فلم تتعلق الرؤية به
مجرداً وأما العرض فليس كل عرض قد تعلقت الرؤية به وإنما يستقيم دليلكم
هذا أن لو تعلقت الرؤية بالجوهر والعرض على الإطلاق والتعمبم حتى يصح منكم
ربط الحكم بجامع بينهما وإذا تعلقت ببعض الأعراض دون البعض فلم يكن الحكم
معلقاً بالعرض من حيث أنه عرض ولا بالجوهر من حيث أنه جوهر ولا يكون
معلقاً بما يجمع بينهما وهو الوجود أو الحدوث فلا بد إذاً من إثبات التعلق
وحصره في شيء دون شيء أو تعميمه بكل شيء وذلك نفس المتنازع فيه.
واعتراض
رابع لم قلتم أن الحدوث لا يكون مصححاً وقد عرفتم أن من الأحكام العقلية
ما يتعلق بالحدوث دون الوجود وليس لقائل أن يقول أن كونه مسبوقاً بعدم ليس
بمؤثر فإن معناه أنه وجود على صفة واعتبار وكما أن المرئي أخص من المعلوم
والرؤية تتعلق بالمعلوم على صفة الوجود كذلك نقول تتعلق بالوجود على صفة
الحدوث وبالحادث على صفة المقابلة أو التكون أو غير ذلك من الصفات
والاعتبارات وهذا السر وهو أن المنقسم ربما يورد أقساماً وينفي بعض
الأقسام مفرداً وربما يكون الحكم معلقاً بمركب من القسمين لا بمفرد بينهما
فكما يجب نفي الأفراد من حيث هي أفراد فكذلك يجب نفي المركب من حيث هو
مركب وهذا مما أغفله المتكلم كثيراً في مجاري تقسيماته وهو واجب الرعاية
جداً.
واعتراض خامس قد تحقق أن الرؤية من جملة الحواس الخمس أفتقولون
أنها كلها تتعلق بالوجود والمصحح لها الوجود أم الرؤية خاصة تتعلق بكل
موجود فإن عممتم الحكم فقد افتتحتم أمراً وهو التزام كونه تعالى مسموعاً
مشموماً مطعوماً ملموساً وذلك شرك عظيم وإن خصصتم الحكم بالرؤية وجب عليكم
إظهار دليل التخصيص فإن قلتم الدليل أنه لا يؤثر في المرئي ولا يتأثر منه
فقيل هو نفس المتنازع فيه وإن قلتم هو علم أو في حكم العلم إلا أنه يقتضي
تعيين المدرك فيقال لكم التعيين قد يكون تعيين العقل ولا شك أن الحس لا
يستدعي ذلك التعيين فإن تعيين العقل كتخصيص العام وتفصيل المجمل وتقييد
المطلق وتحديد الشيء ولا تختص أمثال هذه التعيينات بالرؤية والحس وإن قلتم
التعيين تعيين الحس فهو يستدعي قبول الإشارة إليه وذلك يقتضي حيزاً
ومكاناً وجهة ومقابلةً وهو محال.
قالت الأشعرية الجواب عن الاعتراض
الأول أن طلب المصحح لم يختص بنا فإنكم جعلتم اللون والمتلون مصححاً وذلك
أن الرؤية لما تعلقت ببعض الموجودات وذلك نوعان نوع من الأعراض ونوع من
الجواهر فصح كون الجوهر والعرض مرئياً فقلنا ما المصحح لهذه الصحة أهو كون
الجوهر جوهراً فلزم أن لا يكون العرض مرئياً أو كون العرض عرضاً فلزم أن
لا يكون الجوهر مرئياً فلا بد إذاً من قضية واحدة جامعة بينهما شاملة لهما
حتى تتكون الصحة معللة لها إذ الصحة حكم هو قضية واحدة فلا يكون مصححها
علتان مختلفتان فإن اختلاف العلتين يوجب اختلاف الحكمين في العقليات ولما
تعلقت الرؤية بمختلفات وجب علينا طلب العلة التي لأجلها صح تعلقها بها ولا
بد أن يكون السبب المصحح قضية تجمعهما لا كاللون والمتلون فإنهما قضيتان
مختلفتان اختلاف الجنس والجنس والنوع والنوع ومن المحال ربط حكم واحد
بعلتين مختلفتين فإن العلة العقلية لا بد أن تستقل بإفادة الحكم فإن استقل
أحد المختلفين استغنى الحكم عن الثاني فطلبنا العلة لأن الرؤية تعلقت
بمختلفين وجعلنا العلة قضية واحدة تشملها لاتحاد الحكم وهو الصحة فصح
الطلب وحصل المطلوب.
وأما الجواب عن الاعتراض الثاني وهو إلزام الحال على مذهب أبي الحسن
وإبطال الاشتراك والافتراق على نفي الحال.
قال القاضي أبو بكر الذي ذكرته دليلي وأنا قائل بالحال فسقط الاعتراض.
وقال
أبو الحسن القضايا العقلية والوجوه الاعتبارية لا ينكرها منكر ولسنا ممن
لا يجمع بين مختلفين ولا يفرق بين مجتمعين ولا يقول بوجه ووجه وحيث وحيث
واعتبار واعتبار فإن الحركة إذا قامت بمحل وصف المحل بكونه متحركاً فهي من
حيث أنها حركة وباعتبار أنها حركة أوجبت كون المحل متحركاً وهي باعتبار
أنها كون لها حكم آخر وباعتبار أنها عرض لها حكم آخر ولو رفعنا هذه
الاعتبارات انحسم باب النظر وانحصر نظر العقل على موجودات معينة وبطلت
الاعتبارات بأسرها ولما قطعنا بأن الرؤية تعلقت بجنسي العرض والجوهر عرفنا
أن الصحة على قضية واحدة وإنما نعني بالصحة صلاحية كل جنس لتعلق الرؤية
فتلك الصلاحية صحتها على نعت واحد وإنما العلة المقتضية لتلك الصلاحية يجب
أن تكون على نعت واحد والوجود وإن اختلف بالنسبة إلى المختلفات غير أنه في
العقل والتصور معنى واحد يشمل القسمين فصح أن يكون مناطاً للحكم وهذا كما
قررناه في الجمع بين الشاهد والغائب بالشرط والمشروط والعلة والمعلول
والدليل والمدلول والحقيقة والمحقق.
وأما الجواب عن الاعتراض الثالث
وهو إجمال القول في تعلق الرؤية بالجوهر والعرض قلنا الإنسان يدرك من نفسه
إدراك الحجمية الجوهر وتحيزه وشكله من تدوير وتثليث وتربيع وتخميس إلى غير
ذلك من الإشكال ولهذا يبصر شخصاً من بعد فيدري شخصيته ويشك في لونه وصغره
وكبره كما ذكرنا أسباب ذلك ثم يدرك بعد شكله ولونه فعرف أن الإشكال
والألوان غير والجسم من حيث هو جسم غير في البصر وقد أدركهما البصر جميعاً
فلا بد من مصحح جامع بينهما وذلك ما عيناه ولذلك قلنا أن اللون والمتلون
لن يصلح أن يكون علة لأنه تركيب في العلة ومع كونه تركيباً هو تشكيل فإنهم
يقولون المصحح هو اللون أو المتلون فلا العلة المركبة صالحة ولا التشكيل
في العلة مستعمل فبطل ما نصبوه علة وصح ما نصبناه.
وقولهم لم تتعلق الرؤية بجميع الأعراض.
قلنا
ولو تعلقت حساً بجميع الأعراض ما كنا نحتاج إلى طلب العلة كما لم نحتج إلى
طلب العلة لتعلق العلم بالمعلوم إذ تعلق بكل ما يصح أن يعلم معدوماً أو
موجوداً محالاً أو ممكناً لكنا نطلب العلة لأنها تعلقت بالبعض وكما تعلقت
ببعض الأعراض تعلقت بجميع الأجرام فطلبنا جامعاً ولم نظفر بجامع بين
الجواهر وبعض الأعراض كما صاروا إليه من اللون والمتلون فإن الرؤية تعلقت
باللون كما تعلقت بالاجتماع والافتراق والمماسة والمحاذاة وهي أعراض وراء
اللون فلم يكن بد من تعميم الحكم في كل عرض لعموم الجامع بين الجنسين ولا
إشكال في هذه المسئلة سوى هذه المنزلة وهي ورطة العقول فليتحرز فيها تحرز
الماشي في الوحول.
وأما الجواب عن الاعتراض الرابع نقول الحدوث ليس
يصلح أن يكون مصححاً على المذهبين أما على مذهبكم فلأن بعض الأعراض يستحيل
رؤيته فلو كان الحدوث مصححاً لصح تعلق الرؤية بكل محدث وأما على مذهب أبي
الحسن فلأن الحدوث وجود مسبوق بعدم والعدم لا تأثير له فبقي الوجود مصححاً.
وقولهم معنى قولنا مسبوق بعدم أنه وجود مخصوص لا وجود عام مطلق والوجود
المخصوص باعتبار الحدوث علة مصححة.
قيل
الخصوص في الوجود يجب أن يكون بصفة وجودية راجعة إلى الوجود حتى يصح
مؤثراً في إثبات الحكم وسبق العدم لا يصلح أن يكون مؤثراً في إثبات
الصلاحية والصحة للرؤية فبقي الوجود المطلق ونعني بالصفة الوجودية أن يخصص
الوجود مثلاً بأنه جوهر أو عرض والعرض بأنه كون أو لون فهذه الاعتبارات
مما تؤثر فأما العدم السابق فلا تأثير له والوجود باعتبار عدم سابق لا
يكتسب اعتباراً ووجهاً إلا احتياجاً إلى موجِد وهو باعتبار هذا لا يصلح أن
يكون مصححاً للرؤية والإدراك.
وأما الجواب عن الاعتراض الخامس نقول
الرؤية من جملة الحواس الخمس لكن الحواس مختلفة الحقائق والإدراكات ولكل
حاسة خاصية لا يشركها فيها غيرها وليس منها حاسة تتعلق بجنسي الجوهر
والعرض على وتيرة واحدة بل كلها تتعلق بأعراض ومن شرط تعلقها اتصال جسم
بجسم حتى يحصل ذلك الإدراك عن السمع فإنه لا يستدعي اتصال جسم بجسم ضرورة
بل هو إدراك محض كالرؤية.
ثم اختلف رأي العقلاء في أن المصحح للسمع ما
هو فمنهم من قال هو الوجود كالمصحح للرؤية ومنهم من قال المصحح كونه
موجوداً باعتبار كون المسموع كلاماً والكلام قد يكون عبارة لفظية وقد يكون
نطقاً نفسياً وكلاهما مسموعان ونحن كما أثبتنا كلاماً في النفس ليس بحرف
ولا صوت كذلك نثبت سماعاً في النفس ليس بحرف ولا صوت ثم ذلك السماع قد
يكون بواسطة وحجاب وقد يكون بغير واسطة وحجاب " ما كان لبشر أن يكلمه الله
إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً " فالوحي ما يكون بغير واسطة
وحجاب كما قال تعالى " فأوحى إلى عبده ما أوحى " وكما قال النبي صلى الله
عليه وسلم نفث في روعي وقد يكون من وراء حجاب كما كان لموسى عليه السلام
وكلمه ربه وقد يكون بواسطة رسول وحجاب كما قال تعالى " أو يرسل رسولاً "
وبالجملة نحن نعقل في الشاهد كلاماً في النفس ونجده من أنفسنا كما أثبتناه
ثم يعبر اللسان عنه بالعبارة الدالة عليه ثم يسمع السامع فيصل بعد
الاستماع إلى النفس فقد وصل الكلام إلى النفس بهذه الوسائط فلو قدرنا
ارتفاع هذه الوسائط كلها من البين حتى تدرك النفس كما كانت النفس الناطقة
المتكلمة مشتملة عليه فتحقق كلام في جانب المتكلم وسماع في جانب المستمع
ولا حرف ولا صوت ولا لسان ولا صماخ فإذا تصور مثل ذلك في الشاهد حمل
استماع موسى كلام الله على ذلك وعن هذا قال " إني اصطفيتك على الناس
برسالتي وبكلامي " فالرسالات بواسطة الرسل والكلام من غير واسطة لكنه من
وراء حجاب وأما في حقنا فكلام الله تعالى مسموع بأسماعنا مقروء بألسنتنا
محفوظ في صدورنا وقد تبين الفرق بين القراءة والمقروء في مسئلة الكلام.
ومما
تمسك به الأشعري في جواز رؤية الباري جل جلاله سؤال موسى عليه السلام " رب
أرني أنظر إليك " وجواب الرب تعالى " لن تراني " ووجه الاستدلال أن موسى
عليه السلام هل كان عالماً بجواز الرؤية أم كان جاهلاً بذلك فإن كان
جاهلاً فهو غير عارف بالله تعالى حق معرفته وليس يليق ذلك بجناب النبوة
وإن كان عالماً بالجواز فقد علمه على ما هو به والسؤال بالجائز يكون لا
بالمستحيل وجواب الرب تعالى لن تراني يدل على الجواز أيضاً فإنه ما قال
لست بمرئي لكنه أثبت العجز أو عدم الرؤية من جهة الرائي وعن هذا قال "
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني " إذ الجبل لما لم يكن
مطيقاً للتجلي مع شدته وصلابته فيكف يكون البصر مطيقاً فربط المنع بأمر
جائز ومع جوازه أحال المنع على ضعف الآلة لا على منع الاستحالة أليس لو
كان السؤال أرني أنظر إلى وجهك أو إلى شخصك وصورتك لم يكن الجواب بقوله لن
تراني بل لست بذي شخص وصورة ووجه ومقابلة فدل أن السؤال كان بأمر جائز
فتحقق الجواز وإن قيل لن للتأييد فهو محال من وجهين أحدهما أن لن للتأكيد
لا للتأييد أليس قال إنك لن تستطيع معي صبراً وهو جائز غير محال والثاني
أنه وإن كان للتأييد فليس يدل على منع الجواز بل يدل على منع وقوع الجائز
وإنما استدللنا بالآية لإثبات الجواز وتأييد لن لا ينافيه.
فإن قيل سأل الرؤية لقومه لا لنفسه وإنما سألها إلزاماً عليهم بقول الله
سبحانه لن تراني حيث قالوا أرنا الله جهرةً.
قيل
هذا ما يخالف الظاهر من كل وجه ومع مخالفته لا يجوز أن يسأل النبي سؤالاً
محالاً لقومه وقرينة المقال تدل على أن السؤال كان مقصوراً عليه من كل وجه
إذ قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إلى آخر الآية
ومنع موسى لا ينتهض إلزاماً على القوم بل تقرير الحجة القاطعة على أن الله
تعالى لا يجوز أن يكون مرئياً يكون إلزاماً فكيف نجا موسى من السؤال بلن
تراني ولكن انظر إلى الجبل ولم ينج قومه من السؤال في قولهم أرنا الله
جهرةً إلا بالصاعقة المهلكة والعذاب الأليم ولما قال قومه اجعل لنا إلهاً
كما لهم آلهة لم يلزمهم بالسؤال عن الله تعالى بل أجابهم في الحال إنكم
قوم تجهلون إذ كان السؤال محالاً فكذلك الرؤية لو كانت مستحيلة لأجابهم في
الحال ورفع شبههم بالمقال ومثل هذه الحالة لو قدرت المعتزلة ما استجازوا
تأخير البيان عن وقت الحاجة ولعدوا سؤال المسؤول من مسؤول آخر اتهاماً آخر
على شبهة قد تحققت لهم.
ومما تمسك به قوله تعالى " وجوه يومئذ ناضرة
إلى ربها ناظرة " والنظر إذا تعرى عن الصلات كان بمعنى الانتظار وإذا وصل
بلام كان بمعنى الإنعام وإذا وصل بفي كان بمعنى التفكر والاستدلال وإذا
وصل بإلى تعين للرؤية ولا يجوز حمله على الثواب فإن نفس رؤية الثواب لا
يكون إنعاماً وقد أورد النظر في معرض الإنعام واللفظ نص في رؤية البصر بعد
ما نفيت عنه التأويلات الفاسدة.
واعلم أن هذه المسئلة سمعية أما وجوب
الرؤية فلا شك في كونها سمعية وأما جواز الرؤية فالمسلك العقلي ما ذكرناه
وقد وردت عليه تلك الإشكالات ولم تسكن النفس في جوابها كل السكون ولا
تحركت الأفكار العقلية إلى التفصي عنها كل الحركة فالأولى بنا أن نجعل
الجواز أيضاً مسئلة سمعية وأقوى الأدلة السمعية فيها قصة موسى عليه السلام
وذلك مما يعتمد كل الاعتماد عليه.
القاعدة السابعة عشر
في التحسين والتقبيح وبيان أن لا يجب على الله تعالى شيء من قبيل العقل
ولا يجب على العباد شيء قبل ورود الشرعمذهب
أهل الحق أن العقل لا يدل على حسن الشيء وقبحه في حكم التكليف من الله
شرعاً على معنى أن أفعال العباد ليست على صفات نفسية حسناً وقبحاً بحيث لو
أقدم عليها مقدم أو أحجم عنها محجم استوجب على الله ثواباً أو عقاباً وقد
يحسن الشيء شرعاً ويقبح مثله المساوي له في جميع الصفات النفسية فمعنى
الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله ومعنى القبيح ما ورد الشرع بذم
فاعله وإذا ورد الشرع بحسن وقبح لم يقتض قوله صفة للفعل وليس الفعل على
صفة يخبر الشرع عنه بحسن وقبح ولا إذا حكم به ألبسه صفة فيوصف به حقيقة
وكما أن العلم لا يكسب المعلوم صفة ولا يكتسب عنه صفة كذلك القول الشرعي
والأمر الحكمي لا يكسبه صفة ولا يكتسب عنه صفة وليس لمتعلق القول من القول
صفة كما ليس لمتعلق العلم من العلم صفة.
وخالفنا في ذلك الثنوية
والتناسخية والبراهمة والخوارج والكرامية والمعتزلة فصاروا إلى أن العقل
يستدل به حسن الأفعال وقبحها على معنى أنه يجب على الله الثواب والثناء
على الفعل الحسن ويجب عليه الملام والعقاب على الفعل القبيح والأفعال على
صفة نفسية من الحسن والقبيح وإذا ورد الشرع بها كان مخبراً عنها لا مثبتاً
لها ثم من الحسن والقبح ما يدرك عندهم ضرورة كالصدق المفيد والكذب الذي لا
يفيد فائدة ومنها ما يدرك نظراً بأن يعتبر الحسن والقبح في الضروريات ثم
يرد إليها ما يشاركها في مقتضياتها ثم يرتبون على ما ذكرناه قولهم في
الصلاح والأصلح واللطف والثواب والعقاب.
وقد فرق أبو الحسن الأشعري بين
حصول معرفة الله تعالى بالعقل وبين وجوبها به فقال المعارف كلها إنما تحصل
بالعقل لكنها تجب بالسمع وإنما دليله في هذه المسئلة لنفي الوجوب التكليفي
بالعقل لا لنفي حصول العقلي عن العقل.
قال أهل الحق لو قدرنا إنساناً
قد خلق تام الفطرة كامل العقل دفعة واحدة من غير أن يتخلق بأخلاق قوم ولا
تأدب بآداب الأبوين ولا تزيا بزي الشرع ولا تعلم من معلم ثم عرض عليه
أمران أحدهما أن الاثنين أكثر من الواحد والثاني أن الكذب قبيح بمعنى أنه
يستحق من الله تعالى لوماً عليه لم يشك أنه لا يتوقف في الأول ويتوقف في
الثاني ومن حكم بأن الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقول
وعاند عناد الفضول أو لم يتقرر عنده أن الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا
ينتفع بصدق فإن القولين في حكم التكليف على وتيرة واحدة ولم يمكنه أن يرجح
أحدهما على الثاني بمجرد عقله.
والذي يوضحه أن الصدق والكذب على حقيقة
ذاتية لا تتحقق ذاتهما إلا بأن كان تلك الحقيقة مثلاً كما يقال أن الصدق
أخبار عن أمر على ما هو به والكذب إخبار عن أمر على خلاف ما هو به ونحن
نعلم أن من أدرك هذه الحقيقة عرف التحقق ولم يخطر بباله كونه حسناً أو
قبيحاً فلم يدخل الحسن والقبيح إذاً في صفاتهما الذاتية التي تحققت
حقيقتهما ولا لزمتهما في الوهم بالبديهة كما بينا ولا لزمها في الوجود
ضرورة فإن من الأخبار الصادقة ملا يلام عليها كالدلالة على نبي هرب من
ظالم ومن الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب عليها مثل إنكار الدلالة عليه فلم
يدخل كون الكذب قبيحاً في حد الكذب ولا لزمه في الوهم ولا لزمه في الوجود
فلا يجوز أن يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجوداً وعدماً عندهم
ولا يجوز أن يعد من الصفات التابعة للحدوث فلا يعقل بالبديهة ولا بالنظر
فإن النظري لا بد وأن يرد إلى الضروري البديهي وإذا لا بديهي فلا مرد له
أصلاً فلم يبق لهم إلا استرواح إلى عادات الناس من تسمية ما يضرهم قبحاً
وما ينفعهم حسناً ونحن لا ننكر أمثال تلك الأسامي على أنها تختلف بعادة
قوم دون قوم وزمان وزمان ومكان ومكان وإضافة وإضافة وما يختلف بتلك النسب
والإضافات لا حقيقة لها في الذات فربما يستحسن قوم ذبح الحيوان وربما
يستقبحه قوم وربما يكون بالنسبة إلى قوم وزمان ومكان حسناً وربما يكون
قبيحاً لكنا وضعنا الكلام في حكم التكليف بحيث يجب الحسن فيه وجوباً يثاب
عليه قطعاً ولا يتطرق إليه لوم أصلاً ومثل هذا لا يمتنع إدراكه عقلاً هذه
هي طريقة أهل الحق على أحسن ما تقرر وأوضح ما تحرر.
وقالت الطوائف
المخالفات نحن نعارض الأمرين اللذين عرضا على العقل الصريح بأمرين آخرين
نعرضهما عليه فنقول العاقل إذا سنحت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق كما أمكن
قضاؤها بالكذب بحيث تساويا في حصول الغرض منهما كل التساوي كان اختياره
الصدق أولى من اختياره الكذب فلولا أن الكذب عنده على صفة يجب الاحتراز
عنه وإلا لما رجح الصدق عليه.
قالوا وهذا الفرض في حق من لم تبلغه
الدعوة أو في حق من أنكر الشرائع حتى لا يلزم كون الترجيح بالتكليف وعن
هذا صادفنا العقلاء يستحسنون إنقاذ الغرقى وتخليص الهلكى ويستقبحون الظلم
والعدوان.
وأوضح من هذا كله أنا نفرض الكلام في عاقلين قبل ورود الشرع
يتنازعان في مسئلة تنازع النفي والإثبات فلا شك أنهما يقسمان الصدق والكذب
ثم ينكر أحدهما على صاحبه قوله إنكار استقباح ويقرر كلامه تقرير استحسان
حتى يفضي الأمر بينهما من الإنكار قولاً إلى المخاصمة فعلاً وينسب كل واحد
منهما صاحبه إلى الجهل ويوجب عليه الاحتراز عنه ويدعوه إلى مقالته ويوجب
عليه التسليم فلو كان الحسن والقبيح مرفوضاً من كل جهة لارتفع التنازع
وامتنع الإقرار والإنكار.
وقولكم مثل هذا في العادة جائز جاز ولكنه في حكم التكليف ممتنع.
قلنا
ليس ذلك مجرد العادة بل هو العقل الصريح القاضي على كل مختلفين في مسئلة
بالنفي والإثبات وما حسن في العقل حسن في الحكمة الإلهية وما حسن في
الحكمة وجب وجوب الحكمة لا وجوب التكليف فلا يجب على الله تعالى شيء
تكليفاً ولكن يجب له من حيث الحكمة تقريراً أو تدبيراً.
قالوا لو رفعنا
الحسن والقبح من الأفعال الإنسانية ورددناهما إلى الأقوال الشرعية بطلت
المعاني العقلية التي نستنبطها من الأصول الشرعية حتى لا يمكن أن يقاس فعل
على فعل وقول على قول ولا يمكن أن يقال لم ولأنه إذ لا تعليل للذوات ولا
صفات للأفعال التي هي عليها حتى يربط بها حكم مختلف فيه ويقاس عليها أمر
متنازع فيه وذلك رفع للشرائع بالكلية من حيث إثباتها ورد الأحكام الدينية
من حيث قبولها.
وزادت الفلاسفة على المعتزلة حجة وتقريراً قالوا قد
اشتمل الوجود على خير مطلق وشر مطلق وخير وشر ممتزجين فالخير المطلق مطلوب
العقل لذاته والشر المطلق مرفوض العقل لذاته والممتزج فمن وجه ومن وجه ولا
يشك العاقل في أن العلم بجنسه ونوعه خير محمود ومطلوب والجهل لجنسه ونوعه
شر مذموم غير مطلوب وكل ما هو مطلوب العقل فهو مستحسن عند العقلاء وكل ما
هو مهروب العقل فهو مستقبح عند الجمهور والفطرة السليمة داعية إلى تحصيل
المستحسن ورفض المستقبح سوى حمله عليه شارع أو لم يحمله ثم الأخلاق
الحميدة والخصال الرشيدة من العفة والجود والشجاعة والنجدة مستحسنات فعلية
وأضدادها مستقبحات علمية وكمال حال الإنسان أن تستكمل النفس قوتي العلم
الحق والعمل الخير تشبيهاً بالإله تعالى والروحانيات العلوية بحسب الطاقة
والشرائع إنما ترد بتمهيد ما تقرر في العقول لا بتغييرها لكن العقول
الجزئية لما كانت قاصرة عن اكتساب المعقولات بأسرها عاجزة عن الاهتداء إلى
المصالح الكلية الشاملة لنوع الإنسان وجب من حيث الحكمة أن يكون بين
الإنسان شرع يفرضه شارع يحملهم على الإيمان بالغيب جملة ويهديهم إلى مصالح
معاشهم ومعادهم تفصيلاً فيكون قد جمع لهم بين خصلتي العلم والعمل على
مقتضى العقل وحملهم على التوجه إلى الخير المحض والإعراض عن الشر المحض
استبقاء لنوعهم واستدامةً لنظام العالم ثم ذلك الشارع يجب أن يكون من
بينهم مميزاً بآيات تدل على أنها من عند ربه راجحاً عليهم بعقله الرزين
ورأيه المتين ولفظه المبين وحدسه النافذ ولصره الناقد وخلقه الحسن وسمته
الأرصن يلين لهم في القول ويشاورهم في الأمر ويكلمهم على مقادير عقولهم
ويكلفهم بحسب طاقتهم ووسعهم كما ورد في الكتاب " ادع إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن " .
قالوا وقد أخطأت المعتزلة
حيث ردوا القبح والحسن إلى الصفات الذاتية للأفعال وكان من حقهم تقرير ذلك
في العلم والجهل إذ الأفعال تختلف بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات وليست
هي على صفات نفسية لازمة لها لا تفارقها البتة.
وأخطأت الأشعرية حيث
رفعتهما عن العلم الذي ليس في نوعه ذميم وعن الجهل الذي ليس في نوعه حميد
إذ السعادة والشقاوة الأبدية مخصوصتان بهما مقصورتان عليهما والأفعال
معينات أو مانعات بالعرض لا بالذات وتختلف بالنسبة إلى شخص وشخص وزمان
وزمان.
ثم زادت الصابئة على الفلاسفة بأن قالوا كما كانت الموجودات في
العالم السفلي مرتبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات
للكواكب وفي اتصالاتها نظر نحس وسعد وجب أن يكون في أثرها حسن وقبح في
الخلق والأخلاق والعقول الإنسانية متساوية في النوع فوجب أن يدركها كل عقل
سليم وطبع قويم ولا تتوقف معرفة المعقولات على من هو مثل ذلك العاقل في
النوع " ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم " فنحن لا نحتاج إلى من
يعرفنا حسن الأشياء وقبحها وخيرها وشرها ونفعها وضرها وكما كنا نستخرج
بالعقول من طبائع الأشياء منافعها ومضارها كذلك نستنبط من أفعال نوع
الإنسان حسنها وقبحها فنلابس ما هو حسن منها بحسب الاستطاعة ونجتنب ما قبح
منها بحسب الطاقة فلا نحتاج إلى شارع متحكم على عقولنا بما يهتدى ولا
يهتدي " أبشر يهدوننا " " ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون "
فهذه مقالة القوم ولها شرح ذكرناه في كتابنا الموسوم بالملل والنحل.
وزادت
التناسخية على الصابئة بأن قالت نوع الإنسان لما كان موصوفاً بنوع اختيار
في أفعاله مخصوصاً بنطق وعقل في علومه وأحواله ارتفع عن الدرجة الحيوانية
استسخاراً لها فإن كانت أعماله على مناهج الدرجة الإنسانية ارتفعت إلى
الملكية أو إلى النبوة وإن كانت على مناهج الدرجة الحيوانية انخفضت إلى
الحيوانية أو إلى أسفل وهو أبداً في أحد أمرين إما فعل الجزاء أو جزاء على
فعل كما يقولون كرد وباداشت فما بالنا نقول محتاج في أفعاله وأحواله إلى
شخص مثله يقبح ويحسن فلا العقل يحسن ويقبح ولا الشرع لكن حسن أفعاله جزاء
على حسن أفعال غيره وقبح أفعاله كذلك وربما يصير حسنها وقبحها صوراً
حيوانية وربما يصير الحسن والقبح في الحيوانية أفعالاً إنسانية وليس بعد
هذا العالم عالم جزا يحكم فيه ويحاسب ويثاب ويعاقب.
وزادت البراهمة على
التناسخية بأن قالوا نحن لا نحتاج إلى شريعة وشارع أصلاً فإن ما يأمر به
النبي لا يخلو إما أن يكون معقولاً أو لا يكون معقولاً فإن كان معقولاً
فقد استغنى بالعقل عن النبي وإن لم يكن معقولاً لم يكن مقبولاً.
أجاب
أهل الحق عن مقالة كل فرقة فقالوا للمعتزلة المعارضة غير صحيحة فإن ما
ذكرناه من الفرق بين العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد والحكم بأن الكذب
قبيح ظاهر لا مراء فيه وما ذكرتموه غير مسلم فإنه يستوي عند صاحب الحاجة
طرفاً الصدق والكذب وإن اختار الصدق لم يكن اختياره أمراً ضرورياً ولا
يقارنه العلم بوجوب اختياره ضرورة ولو استروح إليه فلداع أو اعتياد أو غرض
يحمله على ذلك ومن استوى عنده الصدق والكذب في الملام في الحال والعقاب في
ثاني الحال لم يرجح أحدهما على الثاني لأمر في ذاته.
وأما استحسان
العقلاء إنقاذ الغرقى واستقباحهم للعدوان فلطلب ثناء يتوقع منهم على ذلك
الفعل وذم على الفعل الثاني ومثل هذا قد سلمناه ولكنا فرضنا القول في حكم
التكليف هل يستحق على الله ثواب وعقاب بعد أن علم أنه لا يلحقه ضرر ولا
نفع من فعله.
وأما المتنازعان بالنفي والإثبات في أمر معقول قبل ورود
الشرع وإنكار كل واحد منهما على صاحبه فمسلم لكن الكلام وقع في حق الله
تعالى هل يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على ذلك الفعل وذلك غيب عنا
فبم يعرف أنه يرضى عن أحدهما ويثيبه على فعله ويسخط على الثاني ويعاقبه
على فعله ولم يخبر عنه مخبر صادق ولا دل على رضاه وسخطه فعل ولا أخبر عن
محكومه ومعلومه مخبر ولا أمكن أن تقاس أفعاله على أفعال العباد فإنا نرى
كثيراً من الأفعال تقبح منا ولا تقبح منه كإيلام البرئ وإهلاك الحرث
والنسل إلى غير ذلك وعليه يخرج إنقاذ الغرقى والهلكى فإن نفس الإغراق
والإهلاك يحسن منه تعالى ولا يقبح وذلك منا قبيح والإنقاذ إن كان حسناً
فالإغراق يجب أن يكون قبيحاً فإن قدر في ضمن إهلاكه سر لم نطلع عليه أو
غرض لم نوصله إليه إلا به فليقدر في إهلاكنا كذلك والفعل من حيث الصفات
النفسية واحد فلم قبح من فاعل وحسن من فاعل.
وأما ما قدروه من تنازع
المتنازعين في مسئلة عقلية فذلك لعمري من مستحسنات العقول من حيث أن
أحدهما علم والثاني جهل لا من حيث أن أحدهما مكتسب له مستوجب على كسبه
ثواباً على الله تعالى لأنهما وإن اقتسما صدقاً وكذباً وعلماً وجهلاً لم
يستوجبا بشروعهما في النظر ومخاصمتهما على تجاذب الكلام على الله تعالى
ثواباً وعقاباً ولم يعرف بمجرد المناظرة أن حكم الله في حقهما إذا كان
الشروع جائزاً أو محرماً بل يتعارض الأمر بين الجواز والتحريم فوجه الجواز
فيه أنه اشتغال بالنظر والنظر متضمن للعلم والعلم محمود لنفسه وجنسه
والطريق المحمود محمود ووجه التحريم فيه أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه
واشتغال بالنظر وهو مخاطرة وربما يخطي وربما يصيب وإن أخطأ فربما يحصل له
الجهل والجهل مذموم لجنسه ونفسه فمن هذا الوجه أوجب العقل التوقف ومن ذلك
الوجه أوجب الشرع والأمر فيه متعارض وما يستقبح أحدهما من الثاني ليس
استقباحاً يتنازع فيه.
وقولهم ما يحسن من العقل يحسن من حيث الحكمة فيجب على الله حكمة لا
تكليفاً.
قلنا
ما المعنى بقولكم يجب على الله تعالى من حيث الحكمة وما معنى الحكيم
والحكمة فإن عندنا وقوع الفعل على حسب العلم حكمة سواء كان فيه مصلحة وغرض
أو لم يكن بل لا حامل للمبدع الأول على ما يفعله فلو كان فالحامل فوقه
والداعي أعلى منه بل فعله وصنعه على هيئة يحصل منها نظام الموجودات بأسرها
من غير أن يكون له حامل من خارج وغرض وداع من الغير والحكيم من فعل فعلاً
على مقتضى علمه والحسن والأحكام في الفعل من آثار العلم وأما الغير إذا
فعل فعلاً مستحسناً عنده من غير إذن المالك فليس من الحكمة وجوب المجازاة
على ذلك الفعل خصوصاً والمالك لم ينتفع بذلك المستحسن ولا اكتسب زينةً
وجمالاً والحال عنده إن فعل وإن لم يفعل على وتيرة واحدة.
وبقي أن يقال
إذا لم يرجع إلى المالك نفع ولا ضرر فربما يرجع إلى الفاعل فيعارض بأن
يقال ذلك الفعل في الحال مشقة وكلفة مع جواز أن يخطئ فيعاقب في ثاني الحال
حساب وكتاب مع جواز أن يثاب على الصواب فأي عقل يخاطر هذه المخاطرة ويقتحم
هذا الاقتحام وإن رجعوا إلى عادات الناس في شكر المنعم والثناء على المحسن
والتعبد للمالك والعباد للملوك أنها من مستحسنات العقول.
والجواب عنه
من وجهين أحدهما أن العادة لا تكون دليلاً عقلياً يلزم الحكم به ضرورة بل
العادات متعارضة والشكر والكفر سيان في حق من لا ينتفع بشكر ولا يتضرر
بكفر والثاني أن الشكر على النعمة لا يستوجب بسببه نعمة أخرى بل هو قضاء
لواجب ثبت عليه إذا أدى ما وجب عليه لم يستوجب بذلك زيادة نعمة فلا يجب
على الله تعالى ثواب بسبب شكر النعمة ولهذا نقول من أنفق جميع عمره في شكر
سلامة عضو واحد كان يعد مقصراً فإذا قابل قليل شكره بكثير نعم الله تعالى
كيف يكون يعد موفراً وكيف يستحق على المنعم زيادة نعمه وكذلك حكم جميع
العبادات في مقابلة النعم السابغة قليل في كثير ولا يستوجب بسببها ثواب.
ثم
نقول الواجب في حق الله تعالى غير معقول على الإطلاق والاستحقاق للرب على
العبد غير مستحيل حمله فإنه ما من وقت من الأوقات إلا ويتقلب العبد في نعم
كثيرة من نعم الله تعالى ابتداء بأجزل المواهب وأفضل العطايا من حسن
الصورة وكمال الخلقة وقوام البنية وإعداد الآلة وإتمام الأدلة وتعديل
القناة نعم وما متعه به من أرواح الحياة وفضله به من حياة الأرواح وما
كرمه به من قبول العلم وآدابه وهدايته إلى معرفته التي هي أسنى جوائزه
وحبايه " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " فلا ابتداء الإنعام واجب عليه
فعلاً ولا إذا قابل نعمة بشكر يسير كان الثواب واجباً عليه لأنه يعد
مقصراً في أداء شكر ما أنعم عليه فكيف يستحق نعمة أخرى فمن هذا الوجه لا
يثبت قط استحقاق العبد ولا يتحقق قط وجوبه على الرب ثم إن سلم تسليم جدل
أنه يستحسن من حيث العادة الشكر على النعم فكذلك يستحسن من حيث العادة أن
يتقابل العوضان ويتماثل الأمران قدراً وزماناً ولا يتصور أن يقع التقابل
والتماثل بين أكثر كثير النعم وبين أقل قليلها ولا يتحقق التعاوض بين
سرمدي الوجود دواماُ وبين ما لا يثبت له وجود إلا لحظة أو خطرة أو لفظة
كما يقتضي العقل إيجاب شيء في مقابلة شيء مكافأة وجزاء كذلك يقتضي اعتبار
قدر الشيء في مقابلة قدر وبالاتفاق لم يعتبر القدر فيجب أن لا يعتبر الأصل
فإن كنا نستفيد الوجوب من العقل ونعتبر العقل بالعادة فهذا هو قضية العقل
والعادة صدقاً فكيف يثبت مثله استحقاق العبد وجوباً على الله تعالى.
وأما
الوجوب على العبد والاستحقاق لله تعالى فليس من قضايا العقل والعادة أيضاً
فإنه إذا لم يتضرر بمعصية ولا ينتفع بطاعة ولم تتوقف قدرته في الإيجاد على
فعل واحد وحال يصدر من الغير فيستعين به بل كما أنعم ابتداء قدر على
الإنعام دواماً كيف يوجب على العبد عبادة شاقة في الحال لارتقاب ثواب في
ثاني الحال أليس لو رمي إليه زمام الاختيار حتى يفعل ما يشاء جرياً على
نسق طبيعته المائلة إلى لذيذ الشهوات ثم أجزل في العطاء من غير حساب كان
ذلك أروح للعبد وما كان قبيحاً عند العقلاء.
ثم نقول من راس مواجب
العقول في أصل التكليف متعارضة الأصول فإنا نطالب الخصم بإظهار وجه الحسن
في أصل التكليف والإيجاب عقلاً أو شرعاً وقد علم أن لا يرجع إلى المكلف
خير وشر ونفع وضر وزين وشين وحمد وذم وجمال ونكال وإن كانت ترجع هذه
المعاني إلى المكلف لكن والمكلف قادر على إسباغ النعم عليهم من غير سبق
التكليف فتعارض الأمران أحدهما أن يكلفهم فيأمرهم وينهاهم حتى يطاع ويعصى
ثم يثيب ويعاقب على فعلهم والثاني أن لا يكلفهم بأمر ونهي إذ لا يتزين
منهم بطاعة ولا يتشين منهم بمعصية ولا يثيب ثواباً على فعل ولا يعاقب
عقاباً على فعل بل ينعم دواماً كما أنعم ابتداء أليس العقل الصريح يتحير
في هذين المتعارضين ولا يهتدي إلى اختيار أحدهما حقاً وقطعاً فكيف يعرفنا
وجوباً على نفسه بالمعرفة وعلى قالبه بالطاعة أم كيف يعرفنا وجوباً على
الفاطر الباري تعالى بالثواب والعقاب خصوصاً على أصل المعتزلة فإن التكليف
والأمر والإيجاب من الله تعالى مجاز في العقل إذ لا يرجع إلى ذاته صفة
يكون بها آمراً مكلفاً بل هو عالم قادر فاعل للأمر كما هو فاعل الخلق
والعقل إنما يعرفه على هذه الصفة ويستحيل أن يعرفه أنه يقتضي ويطلب منه
شيئاً ويأمر وينهي بشيء فغاية العقل أن يعرفه على صفة يستحيل عليه الاتصاف
بالأمر والنهي فكيف يعرفه على صفة يريد منه طاعة يستحق عليها ثواباً ولا
يريد منه معصية يستحق عليها عقاباً ولا طاعة ولا معصية إذ لا أمر ولا نهي
إذ لم يبعث بعد نبياً فيخلق لأجله كلاماً في شجرة فيسمعه ولو خلق لنفسه
كلاماً فهو مسموع كل الحد ولا له في ذاته كلام يمكن أن يستدل عليه كسائر
صفات ذاته بل أمره ونهيه من صفات فعله بشرط أن لا يدل أمره المفعول
المصنوع على صفة في ذاته فهو مدلول أمره ونهيه إذ خلق في شجرة افعل لا
تفعل لا يدل ذلك على صفة غير كونه عالماً قادراً فليعرف من ذلك أن من نفى
الأمر الأزلي لم يمكنه إثبات التكليف على العبد ولا أمكنه إثبات حكم في
أفعال العباد من حسن أو قبح ويؤدي ذلك إلى نفي الأحكام الشرعية المستندة
إلى قول من ثبت صدقه بالمعجزة فضلاً عن العقلية المتعارضة المستندة إلى
عادات الناس المختلفة بالإضافة والنسب وكثيراً ما نقول من نفى قول الله
فقد نفى الفعل فصار من أوحش الجبرية أعني أثبت جبراً على الله تعالى
وجبراً على العبد من نفى إكساب العباد فقد نفى قول الله صار من أوحش
القدرية أعني قدراً على الله وقدراً على العبد والقدرية جبرية من حيث نفي
الكلام والقول والأمر والجبرية قدرية من حيث نفي الفعل والكسب والمأمور به
فلينتبه لهذه الدقيقة.
وأما ما ذكروه من جواز التنازع بين مختلفين في
مسئلة عقلية وإنكار أحدهما على صاحبه واستقباح مذهبه مسلم ولكن النزاع في
أمر وراءه وهو أنه هل يجب على المتنازعين الشروع في تلك المسئلة وجوباً
يستحق به ثواباً وإذا حصل على علم فهل يستحق به ثواب الأبد وإذا حصل على
جهل فهل يصير به مستحقاً لعقاب الأبد فما دليلكم على نفس المتنازع وقد
عرفتم أن الأمر فيه غيب والإذن فيه من المالك غير موجود وفي التصرف خطر
ومن المعلوم أن من خاض لجة البحر ليطلب درةً وهو غير حاذق الصنعة كان على
خطر الهلاك وربما يصير ملوماً من جهة مالكه إن كان عبداً أو مغرماً من جهة
صاحب المال إن كان شريكاً ثم الاستقباح والاستحسان والإنكار والإقرار
متعارضان عند الخصمين فإن كل واحد منهما يستحسن ما يستقبحه صاحبه يناءً
على إنكاره وقل ما يتفق ارتفاع النزاع بينهما إلا بقاض يكون حكمه في الأمر
وراء حكمهما وعقله أرجح من عقلهما يتحاكمان إليه وذلك هو الذي ينفي الحسن
والقبح من حيث العادة ويثبت الحسن والقبح من حيث التكليف.
وأما ما ذكروه من رفع المعاني المعقولة في مجاري الحركات التكليفية
والأحكام الشرعية فذلك لعمري مشكل في المسئلة.
والجواب
عنه من وجهين أحدهما أن نقول ما من معنى يستنبط من فعل وقول لربط حكم إلا
ومن حيث العقل يعارضه معنى آخر يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة
فيتحير العقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما اعتباراً فحينئذ
يجب على العاقل اعتباره واختياره.
ونضرب له مثلاً فنقول إذا قتل
إنسان إنساناً مثله فيعرض للعقل الصريح هاهنا آراء مختلفة كلها متعارضة
أحدها أن يقتل به قصاصاً ردعاً للعاتي من كل مجترئ وفيه استبقاء نوع
الإنسان وتشفٍ للغيظ من كل قريب وفيه استطابة نفس الإنسان ويعارضه معنى
آخر وهو أنه إتلاف في مقابلة إتلاف وعدوان بإزاء عدوان ولا يحيا الأول
بقتل الثاني وإن كان في الردع إبقاء بالتوقع والتوهم ففي القصاص إهلاك
الشخص بناجز الحال والتحقيق وربما يعارضه معنى ثالث وراءهما فيفكر العقل
أيراعي شرائط أخرى سوى مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل أم
من الدين والطاعة أم من النسب والجوهر فيتحير العقل كل التحير فلا بد إذا
من شارع يقرر من المعاني ما وجب على العبد وحياً وتنزيلاً وإنها ملها رجعت
إلى استنباط عقلك ووضع ذهنك من غير إن كان الفعل مشتملاً عليها فإنها لو
كانت صفات نفسية لاشتملت حركة واحدة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة وليس
معنى قولنا أن العقل يستنبط منها أنها كانت موجودة في الشيء يستخرجها
العقل بل العقل تردد بين إضافات الأحوال بعضها إلى بعض ونسب الأشخاص
والحركات نوعاً إلى نوع وشخصاً إلى شخص فطري مثله من تلك المعاني ما
حكيناه وأحصيناه وربما يبلغ إلى ما لا يحصى فعرف بذلك أن المعاني لم ترجع
إلى الذوات بل إلى مجرد الخواطر الطارئة على العقل وهي متعارضة.
والجواب
الثاني أن نقول لو كان الحسن والقبح والحلال والحرام والوجوب والندب
والإباحة والحظر والكراهة والطهارة والنجاسة راجعة إلى صفات نفسية للأعيان
أو الأفعال لما تصور أن يرد الشرع بتحسين شيء وآخر بتقبيحه ولما تصور نسخ
الشرائع حتى يتبدل حظر بإباحة وحرام بحلال وتخير بوجوب ولما كان اختلفت
الحركات بالنسبة إلى الأوقات تحريماً وتحليلاً أليس الحكم في نكاح الأخت
للأب والأم في شرع أبينا آدم عليه السلام بخلاف الحكم في الجمع بين
الأختين المتباعدتين في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف حل ذلك على
اتحاد اللحمة وحرم هذا على تباعد اللحمة ونحن فربما نتجوز فنضيف الحرام
والحلال إلى الأعيان فنقول الخمر حرام والكلب نجس والماء طاهر وهذا يحرم
لعينه وهذا يحرم لغيره وهذا نجس العين وهذا نجس بعارض وكل ذلك يجوز في
العبارة وإلا فهي كلها أحكام شرعية نزلت منزلة صفات عقلية وأضيفت إلى
الأعيان والأفعال إضافة حكمية والحسن والقبح في الصدق والكذب كالحلال
والحرام في الزنا والنكاح وكالجواز والحظر في البيع والربا.
وقد تمسك
الأستاذ أبو إسحاق بطريق لا بأس به فقال صحة كون الضدين مراداً على البدل
يوجب التوقف مثاله من خاف التلف من شيئين على البدل ولم يكن له دليل يدل
على أحدهما بالتعيين يوجب التوقف في الأمرين.
وقال أيضاً العقل يقضي
بأن من له الإيجاب والإيجاب حقه فصاحب الحق له أن يطلب وله أن لا يطلب
سيما إذا كان مستغنياً عن المطالبة به وعن تحصيله له وقيل الرسالة لا سبيل
إلى معرفة مطالبته للعبد بحقه فإنه ربما يطالب وربما يتفضل بالإسقاط
فيتوقف العقل في ذلك وهذا كله من قبيل تعارض الأدلة في العقل لكن الخصم
يعتذر عن هذا ويقول أحد الطريقين أمن على الحقيقة والثاني مخوف والأخذ
بالأمن أولى فإنه إن أخذ بأنه ربما يطالبه بحقه فإذا أدا حقه أمن من
المعاقبة وإن أخذ بأنه ربما يتفضل خاف لأنه ربما لا يتفضل فإنما يستقيم إن
لو كان التعارض متساوي الطرفين من كل وجه فيتوقف العقل ضرورة.
وقال الأستاذ الشكر يتعب الشاكر ولا ينتفع المشكور فلا فائدة في فعله
لاستواء فعله وتركه.
قال الخصم الشكر ينفع الشاكر ولا يضر المشكور فوجب فعله لترجيح نفعه على
ضره.
قال
الأستاذ ربما يضر الشاكر لأنه قابل كثير نعم الله تعالى بقليل شكره ولا شك
أن من أنعم على إنسان بكثير من النعم خطيره وحقيره فأخذ الحقير يشكر عليه
عد من السفه ووجب اللوم عليه وضرب له حديث الرغيف المعروف.
قال الخصم
ليس الشاكر من يقتصر على بعض النعم أو على الحقير منها بل الشاكر من
يستوعب بشكره جميع النعم ثم ربما يخص بعضها بالذكر تنبيهاً على الباقي.
قال
الأستاذ التعرض لمقابلة النعم بالشكر كفر فإنه رأى المقابلة جزاء وكفاء
وقط ولا يكافئ نعم الله التي لا تحصى بالشكر فإنه إن أوقع شكره في مقابلة
نعمه على أنه يكافيه ليلاً يكون تحت منه فهو كفران محض وإن كان على أنه
ينفعه كما انتفع به فهو كفران صريح فلا النعمة تقبل المقابلة ولا المعاوضة
ولا المنعم يقبل النفع والضر وكيف يحسن الشكر والشكر إنما ينتفع الشاكر إن
لو حصل على رضى المشكور وإذنه فإذا لم يعرف رضاه وإذنه إلا بالسمع فلا
يحسن الشكر إلى بالشرع ولكن لما تربى الإنسان على مناهج الشرع ورأى أهل
الدين يستحسنون الشكر وقرأ آيات تحسين الشكر ظن أن مجرد العقل يقتضي بذلك.
أما
الجواب عن مقالة الفلاسفة قولهم أن الوجود قد اشتمل على خير محض وشر محض
وخير وشر ممتزجين فهو كلام من لم يتحقق الخير والشر ما هو فما المعنى
بالخير أولاً فإن الخير يطلق على كل موجود عندكم وعلى هذا الشر يطلق على
كل معدوم وعلى هذا لم يستمر قولكم الوجود يشتمل على خير مطلق فكأنكم قلتم
اشتمل الوجود على الوجود وهو تكرار غير مفيد ولم يستتب قولكم وعلى شر مطلق
فإن الشر المطلق هو المعدوم والوجود كيف يشتمل على العدم فلم يصح التقسيم
رأساً على أنا إنما فرضنا المسئلة في الحركات التي ورد عليها التكليف فإن
الخير والشر فيها هو المقصود بالحسن والقبح وقد ساعدتمونا على أن حكمها في
الأفعال غير معلوم بالضرورة ولا العقل يهتدي إليه بالنظر لأن ذلك يختلف
بالإضافات والأزمان فبقي قولكم العلم من حيث هو علم محمود وكل محمود مطلوب
لذاته والجهل بالعكس من ذلك فهو مسلم ولكن الطالب إذا حصل له المطلوب فهل
يستوجب على الله ثواباً أم لا وإن لم يحصل بل حصل ضده هل يستوجب عقاباً أم
لا لأن التنازع إنما وقع من حيث التكليف لا من حيث ذات الشيء وصورته.
قالوا
معنى الجزاء عندنا ترتب سعادة وشقاوة أبدية على نفس عالمة أو جاهلة كترتب
صحة وسلامة في البدن على شرب دواء وذلك حاصل له بالضرورة وكترتب مرض وألم
في البدن على شرب سم وذلك حاصل له بالضرورة أيضاً.
قيل إذا كان سعادة
النفس مترتبة على حصول قوى العلم والعمل وخروجهما من القوة إلى الفعل
يحتاج إلى معاناة أمور شديدة ومقاساة أحوال عسيرة من تحصيل المقدمات
والوقوف على كيفية تأديها بالطلب أو المطلوب ولم تكن الفطرة الإنسانية
بمجردها كافية في التحصيل وتعارض الأمر عند العقل يوقف العاقل لئلا يقع في
طريق يفضي به إلى الجهالة الموجبة للشقاوة فإن التوقف أولى من اقتحام
الخطر في المهالك وأيضاً فإن عندكم مخرج العقل من القوة إلى الفعل يجب أن
يكون عقلاً بالفعل فإن العقل بالقوة لا يخرج العقل بالقوة فإنه بعد محتاج
إلى مخرج وليس هذا بذاته يخرج ذاته من القوة إلى الفعل وكما أن الممكن
بذاته لا يترجح أحد طرفي إمكانه على الثاني إلا بمرجح كذلك ما هو بالقوة
فلا يخرج من القوة إلى الفعل إلا بمخرج وكما أن المرجح على الحقيقة ما
انتفى عنه وجوه الإمكان كذلك المخرج على الحقيقة ما انتفى عنه وجوه القوة
كالمرجح لجانب الوجود على العدم في الممكنات هو واجب الوجود بذاته والمخرج
من القوى إلى الفعل هو العقل الفعال فقد اعترفتم بأن لا خالق إلا الله ولا
هادي إلى المعارف ولا موجب للتكاليف المستدعية للجزاء إلا هو بتوسط العقل
الأول الفعال والعقول الجزئية بحكم مناسبتها العقل الأول ربما تشتمل منها
صور المعارف فيعرف الأوائل فطرة وبديهة ثم يرد إليها الثواني والثوالث
نظراً وتفكراً حتى يخرج إلى الفعل وهذا على طريق الجواز والإمكان لا على
طريق الوجوب والضرورة لكن لا يعرف إيجابه وتكليفه على العموم إذ ليس لكل
واحد من نوع الإنسان استعداد الاستمداد منه من كل وجه بل واحد بعد واحد
فذلك هو النبي عندنا فلا تعرف المعارف إلا بالعقل ولا تجب المعارف إلا
بالسمع فلزمكم من حكم قاعدتكم هذه ما أثبتنا وهو لازم ضرورة.
وأما
الجواب عن مقالة الصائبة نقول أنتم منازعون في إثبات تأثيرات الكواكب في
الأجسام السفلية كل المنازعة ولنسلم لكم ذلك تسليم المساهلة فالسعد والنحس
لم يؤثر إلا في الحسن والقبح من حيث الخلقة وذلك غير متنازع فيه وإنما
النزاع بيننا في الحسن والقبح من حيث الأمر ولا شك أن الله تعالى حكم في
أفعال العباد بافعل ولا تفعل وعلى ذلك الحكم جزى في الدار الآخرة.
فنقول
ذلك الحكم غير معلوم ضرورة ولا استدلالاً من حيث العقل فوجب التوقف إلى أن
يرد به سمع وما قالوه من نفي النبوة في الصورة البشرية فتقرر الحجة عليه
في إثبات النبوات وأما المنافع والمضار في الأشياء وكونها معلومة بالعقل
فغير مسلم على الإطلاق فإن طريقتها عند القوم وعند الطبيعيين والأطباء هو
التجربة والتجربة ما لم تتكرر لم تفد العلم والتكرار فيه غير ممكن لاختلاف
طبائع الأشياء بالنسبة إلى مزاج ومزاج وهواء وهواء وتربة وتربة وقط لا
تحصل التجربة في شيء واحد باعتبار واحد وأيضاً فإن الخواص التي هي وراء
كيفيات الأشياء وطبائعها ربما تخالف ما يحصل بالتجربة من الطبائع والخواص
عندهم من فيض النفس الكلية على ماهيات الأشياء وربما تحصل آثار كبيرة من
مجرد عدد يتركب من أعداد مخصوصة وربما تحصل آثار مختلفة من مجرد أمزجة
تتركب من عناصر مخصوصة والمطلع على الماهيات غير الباحث عن الكيفيات
والكميات فلا بد إذاً من إثبات شخص له اطلاع على الكواكب وعلى ما وراء
الكواكب حتى يكون الكل عنده كصورة واحدة فتقرر لخاصية منافع الأشياء
ومضارها من جهة الخواص ويحمل العامة على التسليم ذلك جملةً وسيأتي تقرير
ذلك.
وأما الجواب عن مقالة التناسخية فطريق الرد عليهم أن نبطل مذهبهم
في أصل التناسخ وإنكار البعث في الآخرة فنقول أثبتم جزاء على كل فعل تنتهي
الأفعال عندكم إلى جزاء محض وهل تبتدي الأجزية من فعل محض فإن قضيتم
بالتسلسل فذلك دور محض فإنه إن لم يكن فعل إلا جزاء ولا جزاء إلا على فعل
فلم يكن فعل وجزاء أصلاً فإنه يتوقف كون الجزاء جزاءً على سبق فعل ويتوقف
كون الفعل فعلاً على سبق جزاء فيكون كل واحد منهما متوقفاً على صاحبه
فيكون حكمه حكم توقف المعلول على العلة وتوقف العلة على المعلول وذلك محال
فلا بد من ابتداء بفعل أولي ليس بجزاء والانتهاء إلى جزاء آخر ليس بفعل
وذلك تسليم المسئلة.
ثم نقول ما الدرجة العليا في الخير وما الدرجة
السفلى في الشر عندكم قالوا الدرجة العليا في الخير هي الملكية والنوبة
والدرجة السفلى هي الشيطانية والجنية.
فقيل لهم لو قتل نبي حية فما
ثوابه ولا درجة في الثواب فوق النبوة ولو قتل جني نبياً فما عقابه ولا
درجة في العقاب تحت الجنية فيجب أن يعرى أشرف الطاعات عن الثواب وأكبر
الكبائر عن العقاب.
ومما يبطل التناسخ رأساً إن كان مزاج استعد لقبول
الصورة يلائمها من واهب الصور فإذا فاضت عليه الصورة قارنتها صورة النفس
المستحسنة لزم أن يكون لبدن واحد نفسان وذلك محال.
وأما الجواب عن
مقالة البراهمة سيأتي على استيفاء في مسئلة إثبات النبوات والرد عليهم
فيما يليق بسؤالهم أن الذي يأتي به النبي معقول أو غير معقول.
نقول ما
يأتي به النبي معقول في نفسه أي جنسه معقول ويمكن أن يدركه العقل وليس كل
ما هو معقول الجنس يجب أن يعقله الإنسان فإن العلم بخواص الأشياء وماهيات
الموجودات مما هو معقول الجنس وليس كل إنسان يدركه في الحال فبطل التلبيس
الذي تعلقوا به.
القاعدة الثامنة عشر
في إبطال الغرض والعلة في أفعال الله تعالى وإبطال القول بالصلاح والأصلح
واللطف ومعنى التوفيق الخذلان والشرح والحتم والطبع ومعنى النعمة والشكر ومعنى الأجل والرزق.مذهب أهل الحق أن الله تعالى خلق العالم بما فيه من الجواهر والأعراض وأصناف الخلق والأنواع لا لعلة حاملة له على الفعل سواء قدرت تلك العلة نافعة له أو غير نافعة إذ ليس يقبل النفع والضر أو قدرت تلك العلة نافعة للخلق إذ ليس يبعثه على الفعل باعث فلا غرض له في أفعاله ولا حامل بل علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه.
وقالت المعتزلة الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لحكمة
وغرض والفعل من غير غرض سفه وعبث والحكيم من يفعل أحد أمرين إما أن ينتفع
أو ينفع غيره ولما تقدس الرب تعالى عن الانتفاع تعين أنه إنما يفعل لينتفع
غيره فلا يخلو فعل من أفعاله من صلاح ثم الأصلح هل تجب رعايته قال بعضهم
تجب كرعاية الصلاح وقال بعضهم لا تجب إذ الأصلح لا نهاية له فلا أصلح إلا
وفوقه ما هو أصلح منه ولهم كلام في اللطف وتردد في وجوب ذلك.
وقد قالت
الفلاسفة واجب الوجود لا يجوز أن يفعل فعلاً لعلة لا ليحمد ويتزين بالحمد
والشكر ولا لينتفع أو يدفع الضرر ولا لأمر داع يدعوه ويحمله على الفعل
والعالي لا يريد أمراً لأجل السافل بل الأفعال صدرت عن المبادئ الأول وهي
استندت إلى العقل الفعال وإنما أبدع العقل بلوازمه وأبدع بتوسطه سائر
الأشياء على وجه اللزوم عنه ضرورة إذ ليس يتصور وجود واجب الوجود إلا كذلك.
قالوا
إفادة الخير والصلاح من المنعم تنقسم إلى ما يكون لفائدة وغرض يرجع إلى
المفيد والفائدة تنقسم إلى ما هو مثل المبذول كمقابلة المال بالمال وإلى
ما ليس مثلاً كمن يبذل المال رجاء للثواب والمحمدة أو اكتساب صفة الفضيلة
وطلب الكمال به وهذه أيضاً معاوضة وليس بجود كما أن الأول معاملة وليس
بإنعام بل الجود والإنعام هو إفادة ما ينبغي من غير عوض وغرض فالأول قد
أفاد الجود على الموجودات كلها كما ينبغي على ما ينبغي من غير ادخار ممكن
من ضرورة أو حاجة أو رقبة بحيث لو قدر غيره من الممكنات الوهمية كان نقصاً
في ذلك الموضوع لا كمالاً فكل ذلك بلا عوض ولا فائدة وغيره يتصور أمراً ثم
يعرض له احتياج إلى وجوده فيحتال لوجوده ليتم غرضه به كمن يريد يبني داراً
تصورها أولاً ثم احتاج إليها للاستكنان والسكنى احتال لوجودها آلاتها ليتم
غرضه بها أو من يهب مالاً أو يعطي عطاءً ابتداء أو عقيب سؤال يتصور في
نفسه أولاً اكتساب حمد وجزاء وحمله على ذلك ضعف حال الفقير فرق له رقة
الجنسية فأنعم عليه كان الحامل له على النوال نفع يلحقه أو ضرر يدفعه
وتعالى الخالق الأول عن ذلك ولم يكن تصوره وعلمه من المتصور المعلوم حتى
يكون هو الحامل بل التصور من العلم والمقدور من القدرة هذا كلام القوم وهو
حسن لولا تشبيههم بأمور لا نرتضيها والتزامهم أموراً لا نستقصيها.
فقال
أهل الحق الدليل على أن الباري تعالى غني عن الإطلاق إذ لو كان محتاجاً من
وجه كان من ذلك الوجه مفتقراً إلى من يزيل حاجته فهو منتهى مطلب الحاجات
ومن عنده نيل الطلبات ولا يبيع نعمه بالأثمان ولا يكدر عطاياه بالامتنان
فلو خلق شيئاً ما لعلة تحمله على ذاك أو لداعية تدعوه إليه أو لكمال يكسبه
أو حمد وأجر يحصله لم يكن غنياً حميداً مطلقاً ولا براً جواداً مطلقاً بل
كان فقيراً محتاجاً إلى كسب.
والذي يقرره أن كل صلاح نقدره بالعقل
بالنسبة إلى شخص عارضه صلاح فوق ذلك أو فساد مثل ذلك بالنسبة إلى شخص آخر
فلئن كان الصلاح يقتضي وجوده بالنسبة إلى ذلك الشخص فالفساد يقتضي عدمه
بالنسبة إلى شخص آخر فالسم في أصحاب السموم صلاح وفي غيرهم من الحيوانات
فساد فلو كان الصلاح اقتضى وجوده فالفساد اقتضى عدمه وكما يختلف ذلك
بالأشخاص يختلف الصلاح والفساد بالجزئي والكلي ونحن لا ننكر أن أفعال الله
تعالى اشتملت على خير وتوجهت إلى صلاح وأنه لم يخلق الخلق لأجل الفساد
ولكن الكلام إنما وقع في أن الحامل له على الفعل ما كان صلاحاً يرتقبه
وخيراً يتوقعه بل لا حامل له وفرق بين لزوم الخير والصلاح لأوضاع الأفعال
وبين حمل الخير والصلاح على وضع الأفعال كما يفرق فرقاً ضرورياً بين
الكمال الذي يلزم وجود الشيء وبين الكمال الذي يستدعي وجود الشيء فإن
الأول فضيلة هي كالصفة اللازمة والثاني فضيلة كالعلة الحاملة.
قالت
المعتزلة قد قام الدليل على أن الرب تعالى حكيم والحكيم من تكون أفعاله
على إحكام وإتقان فلا يفعل فعلاً جزافاً فإن وقع خيراً فخير وإن وقع شراً
فشر بل لا بد وأن ينجو غرضاً ويقصد صلاحاً ويريد خيراً ثم إن النفع ينقسم
إلى ما يرجع إلى الفاعل إن كان محتاجاً إليه أو إلى غيره وإن كان الفاعل
غنياً غير محتاج كإنقاذ الغرقى وتخليص الهلكى مستحسن في العقل وربما لا
يكون المنقذ مكتسباً نفعاً ومتوقعاً حمداً أو أجراً وعن ذلك ورد في بعض
الكتب ما خلقت الخلق لا ربح عليهم بل خلقتهم ليربحوا علي.
والذي يقرره أن الحكمة في خلق العالم ظاهرة لمن تأملها بالعقل منصوصة لمن
طلبها في السمع.
أما
العقل فقد شهد بأن الحكمة في خلق العالم إظهار آيات ليستدل بها على
وحدانيته ويتوصل بها إلى معرفته فيعرف ويعبد ويستوجب به ثواب الأبد.
وأما
السمع فآيات القرآن كثيرة منها قوله تعالى " وخلق الله السموات والأرض
ولتجزى كل نفس بما كسبت " ولهذا صار كثير من العقلاء إلى أن أول ما يخلقه
الرب تعالى يجب أن يكون عاقلاً مفكراً لأن خلق شيء من غير من ينظر فيه
باعتبار ويتوسل إلى معرفة الباري تعالى باستبصار عبث وسفه.
قالوا وما
ذكرناه لا ينافي الغنى بل هو كمال الغنى عن خلقه فإن كمال الغنى لا يعرف
إلا باحتياج كل العالم إليه واحتياج العالم إنما يعرفه العالم فيستدل به
على انفراده تعالى بغناه ولله تعالى في كل صنع من صنائعه حكمة ظاهرة وآية
تدل على وحدانيته باهرة لا تنكرها العقول السليمة ولا ينبو عنها إلا
الأوهام السقيمة.
قال أهل الحق مسلم أن الحكيم من كانت أفعاله محكمة
متقنة وإنما تكون محكمة إذا وقعت على حسب علمه وإذا حصلت على حسب علمه لم
تكن جزافاً ولا وقعت بالاتفاق.
وقولكم لا بد وأن ينحو غرضاً ويريد
صلاحاً فما المعنى بالغرض وما المعنى بالصلاح ولا يشك أنكم تفسرون الغرض
باجتلاب نفع أو دفع ضرر إذ القادر الحق على كل شيء والغني المطلق عن كل
شيء متقدس عن الضرر والنفع والألم واللذة ويتعالى عن أن يكون محلاً
للحوادث قابلاً للاستحالة والتغيرات وإن فسرتموه بنفع الغير وصلاحه فما
النفع المطلق وما الصلاح المطلق في خلق العالم بأسره إن قلتم يستدل بوجود
دلائله على وحدانيته.
قيل لكم والحكيم إذا فعل فعلاً لغرض معين وجب أن
يحصل له ذلك الغرض من كل وجه ولا يتخلف غرضه من وجه وإلا فينسب إلى الجهل
والعجز ومن المعلوم أن الغرض الذي عينتموه لم يحصل إذا قدرتم خلق العالم
في الأقل من العقلاء وإن لم يقرر ذلك لم يحصل في الأكثر والغرض إذا كان
معلقاً على اختيار الغير لم يصف عن شوائب الخلاف فلا يحصل على الإطلاق ثم
لو خلقهم ولم يكلفهم لا عقلاً ولا سمعاً وفوض الأمر إليهم ليفعلوا ما
أرادوا يتضرر بذلك أم يلحقه نقص أو يثلم جلاله فعل أو ليست الطيور في
الهوى والسوائم في الفلا تغدو وتروح من غير تكليف فما السر في تخصيص بني
آدم بالتكليف ولم ينتفع به ولا يتضرر بضده.
قالوا ليأتي المكلف بما أمر
به فيثيبه عليه ويعوضه عما فات عليه ويكون التذاذ المكلف بالثواب والعوض
المرتبين على فعله أكثر من التذاذه بنفس التفضل والكرم.
قيل يا لله
العجب من حكمة ما أشرفها ومن سر ما أدقه تعبت عقولكم من شدة التعمق في
استخراج المعاني فقد عاد حكمة الله تعالى في خلق السموات والأرض بما فيها
إلى أن يكون التذاذ المكلف بثواب يناله على عمله أكثر من التذاذه بتفضل
يناله من غير عمل إنا إذا فحصنا عن الأغراض كان الغرض من خلق العالم هو
الاستدلال وكان الغرض من الاستدلال حصول المعرفة وكان الغرض من حصول
المعرفة وجوب الثواب وكان الغرض من الثواب حصول التفرقة بين لذتي المقابلة
والعطية فغرض الأغراض من خلق العالم بما فيه من الجواهر والأعراض ما لا
يجوز أن يكون غرضاً لعاقل ولا يقدر الخالق على أن يخلق لذة في التفضل أكثر
مما يخلقها في الثواب واللذات كلها مخلوقة لله تعالى أولا ينادي المكلف يا
رب مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي يا من لا تنفعه المغفرة
ولا تضره المعصية اغفر لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينفعك حتى يكون ابتهاجي
برحمتك ومغفرتك ألطف من التذاذي بمعرفتي وطاعتي أو لا يعد من غاية اللؤم
وركاكة الهمة أن يهدي فقير هدية حقيرة إلى ملك كبير سجيته البذل والعطايا
من غير سؤال وعرض هدية لنيل ثواب ثم يوجب عليه العوض ويقول التذاذي بما
يقابل هديتي أكثر من عطاياك التي لا تحصى انظر كيف عادت الحكمة الإلهية في
خلق العالم بأسره عند القوم إلى أخس الدرجات في الهمة وأمس الحاجات إلى
المرمة بحيث لا يرتضيه عاقل لإرمام بيته الكثيف فكيف يرتضيه الفاطر لأحكام
صنعه اللطيف فتعالى وتقدس.
وأما الآيات في مثل قوله تعالى " ولتجزى كل
نفس بما كسبت " فهي لام المآل وصيرورة الأمر وصيرورة العاقبة لا لام
التعليل كما قال تعالى " فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً " وقوله
" جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ولتبتغوا من فضله " واعلم أنه
كما لا تتطرق لم إلى ذات الباري تعالى وصفاته لم تتطرق إلى صنائعه وأفعاله
حتى لا يلزم أن يجاب لأنه كذى أو لكونه كذي فلا يقال لم وجد ولم كان
العالم ولا يقال لم أوجد العالم ولم خلق العباد ولم كلف العقلاء ولم أمر
ونهى ولم قدر وقضى " لا يسأل عما يفعل وهم يسألون " .
قالت المعتزلة
نحن على طريقين في وجوب رعاية الصلاح والأصلح فشيوخنا من بغداذ حكموا بأن
الواجب في الحكمة لخلق العالم وخلق من يكون قابلاً للتكليف ثم استصلاح
حاله بأقصى ما يقدر من إكمال العقل والأقدار على النظر والفعل وإظهار
الآيات وإزاحة العلل وكل ما ينال العبد في الحال والمال من البأساء
والضراء والفقر والغنى والمرض والصحة والحياة والموت والثواب والعقاب فهو
صلاح له حتى تخليد أهل النار في النار صلاح لهم وأصلح فإنهم لو أخرجوا
منها لعادوا لما نهوا عنه وصاروا إلى شر من الأول وشيوخنا من البصرة صاروا
إلى أن ابتداء الخلق تفضل وإنعام من الله تعالى من غير إيجاب عليه لكنه
إذا خلق العقلاء وكلفهم وجب عليه إزاحة عللهم من كل وجه ورعاية الصلاح
والأصلح في حقهم بأتم وجه وأبلغ غاية.
قالوا والدليل على المذهبين
أن الصانع حكيم والحكيم لا يفعل فعلاً يتوجه عليه سؤال ويلزم حجة بل يزيح
العلل كلها فلا يكلف نفساً إلا وسعها ولا يتحقق الوسع إلا بإكمال العقل
والإقدار على الفعل ولا يتم الغرض من الفعل إلا بإثبات الجزاء " ولتجزى كل
نفس بما كسبت " فأصل التخليق والتكليف صلاح والجزاء صلاح وأبلغ ما يمكن في
كل صلاح هو الأصلح وزيادات الدواعي والصوارف والبواعث والزواجر في الشرع
وتقدير ألطاف بعضها خفي وبعضها جلي فأفعال الله تعالى اليوم لا تخلو من
صلاح وأصلح ولطف وأفعال الله تعالى غدا على سبيل الجزاء إما ثواب أو عوض
أو تفضل فالصلاح ضد الفساد وكل ما عري عن الفساد يسمى صلاحاً وهو الفعل
المتوجه إلى الخير من قوام العالم وبقاء النوع عاجلاً والمؤدي إلى السعادة
السرمدية أجلاً والأصلح هو إذا صلاحان وخيران فكان أحدهما أقرب إلى الخير
المطلق فهو الأصلح واللطف هو وجه التيسير إلى الخير وهو الفعل الذي علم
الرب تعالى أن العبد يطيع عنده وليس في مقدور الله تعالى لطف وفعل لو فعله
لآمن الكفار ثم الثواب هو الجزاء على الأعمال الحسنة والعوض هو البدل عن
الفائت كالسلامة التي هي بدل الألم والنعيم الذي هو في مقابلة البلايا
والرزايا والفتن والتفضل هو اتصال منفعة خاصة إلى الغير من غير استحقاق
يستحق بذلك حمداً وثناءً ومدحاً وتعظيماً ووصف بأنه محسن مجمل وإن لم
يفعله لم يستوجب بذلك ملاماً وذماً وليس للمعتزلة فيما ذكروه مستند عقلي
ولا مستروح شرعي إلا مجرد اعتبار العادة في الشاهد وتشنيعاً معقولاً ثم
اعتبار الغائب بالشاهد وهم في الحقيقة مشبهة في الأفعال.
فألزمت
الأشعرية عليه التزامات منها قولهم إذا أوجبتم على الله تعالى رعاية
الصلاح والأصلح في أفعاله فيجب أن توجبوا علينا رعاية الصلاح والأصلح في
أفعالنا حتى يصح اعتبار الغائب بالشاهد ولم يجب علينا رعايتهما بالاتفاق
إلا بقدر ما والتعرض للنصب والتعب والنصب لو كان فاصلاً بين الشاهد
والغائب لكان فاصلاً في أصل الصلاح.
ومنها أن القربات من النوافل صلاح فليجب وجوب الفرائض.
ومنها
القضاء بأن خلود أهل النار في النار يجب أن يكون صلاحاً لهم وقولهم بأنهم
لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لا يغني فإن الله تعالى لو أماتهم أو سلب
عقولهم وقطع عقابهم كان أصلح لهم ولو غفر لهم ورحمهم وأخرجهم من النار إذ
لم يتضرر بكفرهم وعصيانهم كان أصلح لهم.
ومنها أن كل ما فعله الرب
تعالى من الصلاح لو كان حتماً عليه لما استوجب بفعل ما شكراً أو حمداً
فإنه في فعله قضى ما وجب عليه وما استوجب عبد بطاعته ثواباً وتفضيلاً فإنه
في طاعته قضى ما وجب عليه ومن قضى دينه لم يستوجب شيئاً آخر.
ومنها
قولهم نحن فرضنا الكلام في إنظار إبليس وإمهاله أكان صلاحاً له وللخلق أم
كان فساداً وفي إماتة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صلاحاً له وللخلق
أم فساداً فإن كان تبقية إبليس صلاحاً مع إضلاله الخلق فهلا كان تبقية
النبي صلى الله عليه وسلم صلاحاً مع هدايته للخلق وكيف صار الأمر بالضد من
ذلك.
ومنها قولكم أنكم حسبتم التكليف لتعريض المكلف للثواب الدائم وإذا
علم الرب أنه لو اخترم العبد قبل البلوغ وكمال العقل لكان ناجياً ولو
أمهله وسهل له النظر لعند وكفر وجحد فكيف يستقيم أن يقال أراد به الصلاح
والأصلح ومن المعلوم أن المقصود من التكليف عند القوم الصلاح والتعريض لا
معنى الدرجات التي لا تنال إلا بالأعمال فيجب أن يكون الرب مسيئاً للنظر
لمن خلقه وأكمل عقله وكلفه مع العلم بأنه يهلك ويخسر ولزم من حيث الحكمة
أن يكون علمه مانعاً له عن إرادته والتعريض لمن هذه حاله بالنفع والثواب
وفي العادة كل من عرف من حال ولده أنه لو سافر واتجر في مال يعطيه لهلك
وخسر لا يحسن من حيث العقل أن يبعثه لأجل التجارة ويعطيه المال لأجل
الخسارة ولو علم من ولده أنه لو أعطاه سيفاً وسلاحاً ليقاتل عدواً من
أعدائه لقتل نفسه ويبقى السلاح لعدوه لم يكن من الحكمة أن يعطيه السلاح
ويبعثه للقاء عدوه البتة بل لو فعل ذلك كان ساعياً في هلاك ولده.
ومن
مذهبهم أن الرب تعالى لو علم أنه لو أرسل رسولاً إلى خلقه وكلفه الأداء
عنه مع علمه بأنه لا يؤدي فإن علمه به يصرفه عن إرادته الأداء عنه فكذلك
لو علم أنه يكفر ويهلك وجب أن يصرفه عن إرادته الخير والصلاح له وهذا
بمثابة من أدلى حبلاً إلى غريق ليخلص به نفسه مع العلم بأنه يخنق نفسه فقد
أساء النظر له بل قصد به هلاكه.
ومن مذهبهم أن الرب إذا علم أن في تكليفه عبداً من العباد فساد الجماعة
فإنه يقبح تكليفه لأنه استفساد لمن يعلم أنه يكفر عند تكليفه.
ومن الإلزامات أن القوم قضوا بأن الرب تعالى قادر على التفضل بمثل الثواب
فأي غرض في تعريض العباد للبلوى والمشاق.
قالوا
الغرض فيه أن استيفاء المستحق أهنأ وألذ من قبول التفضل وهذا كلام من لم
يعرف الله حق معرفته وكيف يستنكف العبد وهو مخلوق مربوب من قبول فضل الله
تعالى فلو خلق الخلق وأسكنهم الجنة كان حسناً منه ولو خلقهم في الدنيا ثم
أماتهم من غير تكليف كان حسناً " ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب
العالمين " أليس لو خلقهم وكلفهم وقطع عنهم الألطاف كانوا أبلغ في
الاجتهاد وأحمل للمشاق فكان الثواب لهم أكثر والالتذاذ بما يستحقونه من
العوض أشد فهلا قطع عنهم الألطاف بأسرها لتكون اللذة في الثواب أوفر.
ثم
نلزمهم فرض الكلام في طفلين أحدهما اخترمه قبل البلوغ لعلمه بأنه لو بلغ
لكفر فصار الصلاح في حقه الاخترام حتى لا يستوجب عقاب النار والآخر أوصله
إلى البلوغ والتكليف فكفر فيقول يا رب هلا اخترمتني قبل البلوغ كما اخترمت
أخي حتى لا يتوجه على تكليف يوجب عقاب الأبد وطفلين آخرين اخترم أحدهما
قبل البلوغ وهو ابن كافر وقد علم أنه لو بلغ لأمن وأصلح والآخر أوصله إلى
البلوغ وهو ابن مسلم فكفر وأفسد فيقول هلا اخترمتني حتى لا أستوجب عقاب
الأبد وبالجملة من أوجب رعاية الصلاح والأصلح يوجب اخترام الأطفال الذين
علم الله تعالى منهم الكفر بعد البلوغ حتى لا يوجد كافر في العالم وإبقاء
الأطفال الذين علم الله تعالى منهم الإيمان حتى لا يتحقق إلا الإيمان
والمؤمن في العالم والصلاح يدور على المعلوم كيف كان ثم ما من أصلح إلا
وفوقه أصلح والاقتصار على مرتبة واحدة كالاقتصار على الصلاح فلا معنى
للأصلح ولا نهاية له ولا يمكن في العقل رعايته.
ثم للمعتزلة في الآلام
وأحكامها كلام وهو على مذهب الأشعري لا تقع مقدورة لغير الله وإذا وقعت
كان حكمها الحسن سواء وقعت ابتداءً أو وقعت جزاء من غير تقدير سبق استحقاق
عليها ولا تقدير جلب نفع ولا دفع ضرر أعظم منها بل المالك متصرف في ملكه
كما شاء سواء كان المملوك برياً أو لم يكن برياً ومن صار من الثنوية إلى
أن الآلام والأوجاع والغموم منسوبة إلى الظلمة من دون النور فقد سبق الرد
عليهم ومن نسبها إلى أعمال سبقت لغير هذا الشخص فهو مذهب التناسخية فقد
سبق الرد عليهم بقي استرواح العقلاء إلى أهل العادة يستقبحون الآلام من
غير سبق جناية والآلام مما يأباه العقل وإذا اضطر إليه رام الخلاص منه فدل
ذلك على قبحه ونحن لا ننازعهم في أن الآلام ضرر وتأباه النفوس وتنفر منه
الطباع ولكن كثيراً من الآلام مما ترضاه النفوس وترغب إليه الطباع إذا كان
ترجو فيها صلاحاً هو أولى بالرعاية مثل الحجامة والصبر على شرب الدواء
رجاء للشفاء ونرى كثيراً إيلام الصبيان والمجانين وشرط العوض فيه يزيد في
قبحه والمالك قادر على التفضل بحسن العوض عالم بأن الصلاح في الإيلام
وبالجملة هو المتصرف في ملكه له التصرف مطلقاً كما شاء يفعل ما يشاء ويحكم
ما يريد.
وللفريقين في التوفيق والخذلان والشرح والطبع وأمثالها كلام على طرفي
الغلو والتقصير والحق بينهما دون الجائز منهما.
قالت
المعتزلة التوفيق من الله تعالى إظهار الآيات في خلقه الدالة على وحدانيته
وإبداع العقل والسمع والبصر في الإنسان وإرسال الرسل وإنزال الكتب لطفاً
منه تعالى وتنبيهاً للعقلاء من غفلتهم وتقريباً للطرق إلى معرفته وبياناً
للأحكام تمييزاً بين الحلال والحرام وإذ فعل ذلك فقد وفق وهدى وأوضح
السبيل وبين المحجة وألزم الحجة وليس يحتاج في كل فعل ومعرفة إلى توفيق
مجرد وتسديد منجز بل التوفيق عام وهو سابق على الفعل والخذلان لا يتصور
مضافاً إلى الله تعالى بمعنى الإضلال والإغواء والصد عن الباب وإرسال
الحجاب على الألباب إذ يبطل التكليف به ويكون العقاب ظلماً.
قالت
الأشعرية التوفيق والخذلان ينتسبان إلى الله تعالى نسبة واحدة على جهة
واحدة فالتوفيق من الله تعالى خلق القدرة الخاصة على الطاعة والاستطاعة
إذا كانت عنده مع الفعل وهي تتجدد ساعة فساعة فلكل فعل قدرة خاصة والقدرة
على الطاعة صالحة لها دون ضدها من المعصية فالتوفيق خلق تلك القدرة
المتفقة مع الفعل والخذلان خلق قدرة المعصية وأما الآيات في الخلق فنسبتها
إلى الموفق كنسبتها إلى المخذول والقدرة الصالحة للضدين أعني الخير والشر
إن كانت توفيقاً بالإضافة إلى الخير فهي خذلان بالإضافة إلى الشر.
والقصد
بين الطريقتين أن يقسم التوفيق قسمة عموم وخصوص على عموم الخلق وخصوصهم
فعموم الخلق في توفيق الله تعالى الشامل لجميعهم وذلك نصب الأدلة والأقدار
والاستدلال وإرسال الرسل وتسهيل الطرق لئلا يكون للناس على الله حجة بعد
الرسل وخصوص الخلق في توفيق الله الخاص لمن علم منه الهداية وإرادته
الاستقامة وذلك أصناف لا تحصى وألطاف لا تستقصى تبتدئ من كمال الاعتدال في
المزاج أحدهما من جهة الطبيعة طيناً والثاني من جهة الشريعة خلالاً وهذا
في النطفة الحاصلة من الأبوين وعلتها النقش الأول من السعادة والشقاوة كما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي
في بطن أمه ثم التربية من الأبوين أو من الأستاذ أو من المعلم أو من أهل
البلد وذي القرابة والخلطة معونة أخرى قوية حتى ربما يغير الاعتدال من
النقص إلى الكمال وعن الكمال إلى النقص وعلة النقش الثاني من الفطرة
والاحتيال كما قال عليه السلام فطر الله العباد على معرفته فاحتالتهم
الشياطين عنها وقال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه
ويمجسانه ثم الاستقلال بحالة البلوغ وكمال العقل يحتاج إلى قوي استمداد من
التوفيق وذلك مزلة الأقدام ومجرة الأقلام فالتوفيق فيها من الله أن لا
يكله إلى نفسه مما هي عليها من الاستقلال والاستبداد والخذلان أن يخذله
ويكله إلى نفسه وحوله وقوته وعن هذا كان التبري من الحول والقوة بقولهم لا
حول ولا قوة إلا بالله واجباً في كل حال وذلك مطردة الشياطين إذ يدخل
احتيال الشيطان تغريره بحوله وقوته والفطرة هي الاحتياج إلى الله تعالى
والتسليم لله والتوكل على الله إذ لا حول ولا قوة إلا بالله وذلك كنز من
كنوز الجنة وهذه الحالة أعني حالة البلوغ والاستقلال هي مثار القوى
الحيوانية منها الغضبية والشهوية قال الصديق الأول يوسف عليه السلام وما
أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وذلك عند مثار القوى
الشهوية ووكز الكليم عليه السلام ذلك القبطي فقضى عليه فقال هذا من عمل
الشيطان وذلك عند مثار القوة الغضبية وتبرأ الرسول عليه السلام من القوتين
جميعاً فقال في كل حال اللهم واقيةً كواقية الوليد رب لا تكلني إلى نفسي
طرفة عين وعلى هذه الحالة النفس الثالثة وهي تمتد إلى آخر العمر فلا تزيده
مواعظ الشرع ترغيباً وترهيباً ولا تجانبه مواقع التقدير تنبيهاً وتحذيراً
فإن انفتح سمعه لمواعظ الشرع وبصره لمجاري التقدير انشرح صدره للإسلام فهو
على نور من ربه وإن جعل إصبعه في أذنيه فلم يسمع الآيات إلا مرية وأسبل
جفنه على عينيه فلم يبصر الآيات الخلقية صار على ظلمة من طبعه وذلك الطبع
والختم بل طبع الله عليها بكفرهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى
أبصارهم غشاوة وربما يكون الختم والطبع من قساوة في جوهر جبلية اكتسبها من
أصل فطرته فالتقدير مصدر والتكليف مظهر والكل مقدر والمقدر ميسر لما خلق
له فالحاصل أن الموكول إلى حوله وقوته في خذلان الله تعالى والتوكل على
حول الله وقوته في توفيق الله تعالى فعلى رأي القدرية العبد أبداً في
الخذلان إذ هو موكول إلى حوله وقوته ولم يستعن بالله ولم يتوكل على الله
فعلى رأي الجبرية العبد أبداً في الخذلان إذ هو خاذل نفسه عن امتثال أمر
الله تعالى لم يعبد الله ولم يحفظ حدود الله تعالى.
والحق الذي لا غبار
عليه إياك نعبد محافظة على العبودية وإياك نستعين استعانة بالربوبية
والتوفق والخذلان والشرح والطبع والفتح والختم والهداية والضلال ينتسب إلى
الله تعالى بشرط أن يكون أحق الاسمين به أحسن الاسمين " ولله الأسماء
الحسنى فادعوه بها " وأولى الفعلين بحكمه وتقديره أولى الفعلين وجوداً
وأجدرهما حصولاً " بيدك الخير إنك على كل شيء قدير " اللهم من أحسن فبفضلك
يفوز ومن أساء فبخطيته يهلك لا المحسن استغنى عن رفدك ومعونتك ولا المسيء
عليك ولا استبد بأمر خرج به عن قدرتك فيا من هكذا لا هكذا غيرك صل على
محمد وعلى آله افعل بي ما أنت أهله إنك أهل لكل جميل.
والقول في
النعمة والرزق قريب مما ذكرناه فمن راعى فيهما عموماً قال النعمة كل ما
ينعم به الإنسان في الحال والمال والرزق كل ما يتغذى به من الحلال والحرام
وقد سماها الله تعالى باسمها فقال " وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى
بجانبه " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ومن راعى فيهما خصوصاً
قال النعمة في الحقيقة ما يكون محمود العاقبة وهو مقصور على الدين قال
الله تعالى فيهم " أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في
الخيرات بل لا يشعرون " والرزق في الحقيقة ما يكون مباحاً شرعاً قال الله
تعالى " أنفقوا مما رزقناكم " والحرام لا يجوز الإنفاق منه وكلا القولين
صحيح إذا اعتبر فيهما الخصوص والعموم ولا مشاحه في المواضعات والشكر على
النعم والأرزاق واجب وهو أن تراها بقلبك من المنعم فضلاً فتحمده قولاً ولا
تستعملها في المعاصي فعلاً والأرزاق مقدرة على الآجال والآجال مقدورة
عليها ولكل حادث نهاية ليس تختص النهايات بحياة الحيوانات وما علم الله إن
شاء ينتهي عند أجل معلوم كان الأمر كما علم وحكم فلا يزيد في الأرزاق زائد
ولا ينقص منها ناقص فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون وقد قيل
أن المكتوب في اللوح المحفوظ حكمان حكم مطلق بالأجل والرزق وحكم مقيد بشرط
إن فعل كذا يزاد في رزقه وأجله وإن فعل كذا نقص منهما كذا وعليه حمل ما
ورد في الخبر من صلة الرحم يزيد في العمر وقد قال تعالى " وما يعمر من
معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب " وقوله " يمحو الله ما يشاء ويثبت
وعنده أم الكتاب " .
القاعدة التاسعة عشر
في إثبات النبوات
وتحقيق المعجزات ووجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام صارت البراهمة والصابئة إلى القول باستحالة النبوات عقلاً وصارت المعتزلة وجماعة من الشيعة إلى القول بوجوب وجود النبوات عقلاً من جهة اللطف وصارت الأشعرية وجماعة من أهل السنة إلى القول بجواز وجود النبوات عقلاً ووقوعها في الوجود عياناً وتنتفي استحالتها بتحقيق وجودها كما ثبت تصورها بنفي استحالتها.فقالوا بم يعرف صدق المدعي وقد شاركناه في النوعية والصورة أبنفس دعواه وقد علم أن الخبر محتمل للصدق والكذب أم بدليل آخر يقترن به وذلك الدليل إن كان مقدوراً له فهو أيضاً مقدورنا وإن لم يكن مقدوراً له ولكنه مقدور بقدرة الله تعالى فلا يخلو إما أن يكون فعلاً معتاداً ولا يختص ذلك بهذا المدعي فلا يكون دليلاً وإن كان فعلاً خارقاً فمن أي وجه يدل على صدقه والفعل من حيث هو فعل لا يدل على الاختصاص بشخص معين سوى اقترانه بنفس دعواه وللاقتران أسباب أخر محتملة كما لخرق العادات أحوال مختلفة وإذا احتملت الوجوه عقلاً لم تتعين جهة الدلالة فانحسم باب الدليل من كل وجه أما نفس الإقتران فربما لا يتفق في بعض الأحوال إذ الفعل فعل الله تعالى وهو منوط بمشيئته فكيف يوجب المعدي على الله فعلاً يفعله في تلك الحال وليس يدعي النبي على أصلكم هذه الدعوى التي قدرتموها فإنه يحيل خلق الآيات على مشيئة الله تعالى كما أخبر كتابكم " قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون " وكم من نبي سئل إظهار الآية فلم يظهر في الحال على يده فلئن كان ظهور الآية في بعض الأوقات دليلاً على صدقه فعدم ظهورها في بعض الأوقات يجب أن يكون أيضاً دليلاً على كذبه وليس الأمر كذلك على أصلكم فإذا قال واحد من عرض الناس وهو مجهول الحال عند الكل إني رسول الله إليكم فطولب بالآية وجب عليه التضرع إلى الله في استدعاء الآية الخارقة للعادة على مقتضى الدعوى ووجب على الله إجابته في الحال إلى ذلك كان الإيجاب أولى على الله ورسوله من الخلق وهو عكس ما رمتم إثباته ثم مسئلة النظر والاستمهال فيه يفضي إلى إفحام الأنبياء فإنه إذا ادعى الرسالة فقال المدعو العلم بالرسول يترتب على العلم بالمرسل والعلم به ليس يقع بديهة وضرورة فلا بد من نظر واستدلال في أفعاله استدلالاً بتغيرها على حدوثها وبحدوثها على ثبوت محدثها ثم النظر في قدمه ثم النظر في وحدانيته ثم النظر في صفاته الواجبة له والجائزة عليه وما يستحيل في صفته وبعد ذلك ينظر في جواز انبعاث الرسل ثم في معجزة هذا المدعي بعينه.
فيقول أمهلني حتى أنظر
في هذه الأبواب وأقطع هذه المراتب فهل يجب على النبي إمهاله أم لا فإن لم
يمهل فقد ظلمه إذ كلفه ما لا يطيق وذلك أن العلم إذا لم يحصل إلا بالنظر
والنظر يستدعي مهلة وزماناً ولم يمهله فقد ظلمه وأمره بمجرد التقليد
والتقليد إما كفر وإما قبيح وإذا أمهله فيلزمه أن لا يعود إليه حتى ينتهي
النظر نهايته ولا يتقرر ذلك بزمان معين بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص
وأذهانهم وكياستهم في مدارج النظر وأيضاً فمن استمهل ووجب إمهاله يعطل
النبي عن الدعوة فإن عاد إليهم قالوا نحن بعد في مهلة النظر فليس لك علينا
حكم بعد الإمهال ولم يثبت عندنا صدقك فنتبعك ثم إذا كان النبي مبلغاً عن
الله تعالى فلا بد وأن يسمع أمره وكلامه أولاً ثم يبلغ عنه أو يسمع من سمع
منه فبم عرف النبي بأن المتكلم هو الله أو بم عرف أن المتوسط ملك يوحي
إليه وبم عرف ذلك الملك أن الرب هو الآمر المتكلم فما الجواب عن هذه
المسئلة هذا كلامنا على نفس الدعوى.
أما الكلام على بينة الدعوى فنحن
أولاً ننكر ما حكيتموه عن الأنبياء من قلب العصا حية وإحياء الموتى وفلق
البحر وخروج الناقة من الصخرة الصماء وتسبيح الحصا وانشقاق القمر فإن جنس
ذلك مستحيل الوجود فنحن أولاً نمنع حصولها فماذا دليلكم على وقوع ذلك ثم
بم تنكرون على من يرد الخوارق إلى خواص الأشياء فإنا نجد حصول أمثال ذلك
من الجمادات على يد من لا دين له كالأمطار التي تحصل من اصطكاك الأحجار
وكالرياح التي تهب من تحريك ما مخصوص ثم التعزيم والتنجيم والتبخير وعلم
الطلسمات واستسخار الروحانيات واستخدام الكواكب العلوية علوم معروفة
والعمل بها من العجائب المعجزة والغرائب المفحمة فما أنكرتم أن ما أتى به
هذا المدعي من جنس ذلك ثم الواجب عليكم أن تثبتوا وجه دلالة المعجزة على
الصدق فإنه من حيث هو فعل دل على قدرة الفاعل فقط من هذا الوجه لم يدل على
صدق قول المدعي من حيث اقترانه بدعواه لم يدل أيضاً لأن اقترانه بدعواه
كاقترانه بحدوث حادث آخر من قول أو عمل ثم لم يدل نفس الاقتران على حق أو
باطل فكيف دل هاهنا وأيضاً فإن عندكم يجوز خرق العادات على يدي مدعي
الإلاهية ولم يدل ذلك على صدق دعواه فكيف يدل على صدق دعوى النبوة.
قال
أهل الحق قام الدليل على أن الرب تعالى خالق الخلق ومالكهم ومن له الأمر
والخلق والملك له أن يتصرف في عباده بالأمر والنهي وله أن يختار منهم
واحداً لتعريف أمره ونهيه فيبلغ عنه إليهم فإن من له الخلق والإبداع له
الاختيار والاصطفاء " وربك يخلق ما يشاء ويختار " فلا استحالة في هذه
المراتب ولا استحالة في نفس الدعوى ولا يضاهي استحالته استحالة دعوى
الإلاهية بل هو من الجائزات العقلية فله الواجبات الحكمية فبقي كون الخبر
والدعوى على احتمال الصدق والكذب وإنما ترجح الصدق على الكذب بدليل.
وللمتكلمين
طرق في إثبات المرجح أحدها أن اقتران المعجزة بدعوى النبي نازل منزلة
التصديق بالقول وذلك أنه متى عرف من سنة الله تعالى أنه لا يظهر أمرا
خارقاً للعادة على يدي من يدعي الرسالة عند وقت التحدي والاستدعاء إلا
لتصديقه فيما يجري به واجتماع هذه الأركان انتهض قرينة قطعية دالة على صدق
المدعي فكان المعجزة بالفعل كالتصديق شفاهاً بالقول ونحن نعلم قطعاً في
صورة من يدعي الرسالة من ملك حاضر محتجب بستر والجماعة على كثرتها حضور ثم
إن رجلاً من عرض الناس إذا قام بين يدي ذلك الجمع الكثير من الخلق وقال
أيها الناس إني رسول هذا الملك إليكم وآية صدقي في دعواي أنه يحرك هذا
الستر إذا استدعيت منه ثم قال أيها الملك إن كنت صادقاً في دعواي الرسالة
عنك فحرك هذا الستر فحرك في الحال علم قطعاً ويقيناً بقرينة الحال أنه
أراد بذلك الفعل تصديق المدعي ونزل التحريك منه على خلاف العادة منزلة
التصديق بالقول ولم يشك واحد من أهل الجمع أن الأمر على ما يجري به المدعي
فكذلك في صورة مسئلتنا هذه فإذاً المرجح للصدق هي القرائن الحاصلة من
اجتماع أمور كثيرة منها الخارق للعادة ومنها كونه مقروناً بالدعوى ومنها
سلامته عن المعارضة فانتهضت هذه القرائن بمجموعها دالة على صدق المدعي
نازلة منزلة التصديق بالقول وذلك مثل العلم الحاصل من سائر القرائن أعني
قرائن الحال وقرائن المقال.
ووجه آخر الآية الخارقة للعادة كما دلت
بوقوعها على قدرة الفاعل وباختصاصها على إرادته وبأحكامها على علمه كذلك
دلت بوقوعها مستجابة لدعاء الداعي لا لدعوى المدعي على أن له عند الله
حالة صدق ومقالة حق ومن كانت دعوته مستجابة عند الله يستحيل أن يكون في
دعواه كاذباً على الله تعالى وهذا هو حقيقة النبوة وذلك أن استجابته في
أمور لا يقدر الخلق على ذلك دليل على صدق هذا الداعي ولو قدر الداعي
كاذباً في نفسه على الله أقبح كذب وهو الرسالة عنه بما لم يرسل انقلب دليل
الصدق دليلاً على الكذب وهو متناقض ونحن لا ننكر أن يكون شخص من الأشخاص
مستجاب الدعوة ثم ينقلب حاله إلى حالة الأشقياء كما لا ننكر أن يظهر خارق
للعادة على يد ساحر لكن الشرط في الأمرين واحد وهو أن يكون المدعي في حال
ما يدعي مستجاب الدعوة بالآية حتى تكون الآية دالة على صدق حالته ودرجته
عند الله تعالى وإذا قدر كونه كاذباً انقلبت الدلالة على الصدق دلالة على
الكذب وهو محال لتناقضه وكما أن الوقوع إذا دل على القدرة لم يدل على
العجز والإحكام لما دل على العلم لم يدل على الجهل كذلك دليل الصدق لا
يجوز أن يكون دليلاً على الكذب وهذه الطريقة أحسن من الأولى.
ووجه آخر
نقول إن قرينة الصدق ملازمة لتحدي النبي الصادق عن الله تعالى وذلك أن
المعجزة تنقسم إلى منع المعتاد وإلى إثبات غير المعتاد أما المنع فكالجنس
من الحركات الاختيارية مع سلامة البنية وإحساس التيسير والثاني في مجرى
العادة ومثال ذلك تيه بني إسرائيل في قطع الطريق ومنع السحرة من التخييل
وحصر زكريا من الكلام المعتاد ويجوز أن يقدر صرف الدواعي عن المعارضة بمثل
ما جاء به النبي عليه السلام من جنس المعجزات وإن كان ذلك من قبيل
مقدوراتهم ولهذا عد بعضهم إعجاز القرآن من هذا القبيل وهو مذهب مهجور
ويجوز أن يقدر منع الناس عن التحدي بمثل ما تحدى به النبي من جنس المعجزات
فلا يقدر أحد على المعارضة بالدعوى فضلاً عن معارضته بالخارق للعادة ويكون
لهذه المعجزة قرينة متصلة بنفس الدعوى حتى لا تخلو قط دعوى نبي من
الأنبياء عن قرينة الصدق ولا تتأخر الدلالة عن نفس التحدي وهذا أبلغ في
باب الإعجاز فإن المتصدي للمعارضة يحس من نفسه عجزاً مع استمرار عادته
بمثل ذلك التحدي فيقول النبي إني رسول الله إليكم وآية صدقي أن لا يعارضني
معارض في نفس دعواي هذه والنفوس متطلعة والألسن سليمة والدواعي باعثة
فتتحير العقول وتنحصر الألسن وتتراجع الدواعي وتنمحق الدعاوي لست أقول لا
ينكره منكر بل أقول لا يعارضه معارض بمثل التحدي والدعوى فيقول لا بل إني
رسول الله إليكم ولهذا لم نجد في قصص الأنبياء من عارضهم بمثل دعواهم في
حال التحدي ولا استمرت هذه الدعوى لأحد من بعدهم ولا يلتفت إلى ما يحكى عن
مسيلمة الكذاب أنه ادعى الرسالة عن الله تعالى فإن من كتب إلى نبي الله
أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفين لم يكن معارضاً له في نفس دعواه بل
مسلماً له من وجه ومتحكماً من وجه ومن ادعى الرحمانية في الحالة الثانية
لم يكن ثابت القدم على الدعوى الأولة وكان من حقه لو كان متنازعاً له أن
يقول إني عبد الله ونبيه لا شريك الله في الرحمانية وشريك رسوله في الأرض
فاعرف هذه الدقيقة فإن فيها سراً وغوراً.
ثم الجواب عن شبهات المنكرين
أن نقول قولكم أن اقتران المعجزة بدعوى المدعي لا ينتهض دليلاً على صدقه
فإن نفس الاقتران بالإضافة إلى دعواه أو إلى غيرها من الأفعال أو الأقوال
بمثابة واحدة.
فنقول سبيل تعريف الله تعالى عباده صدق الرسل بالآيات
الخارقة للعادة كسبيل تعريفه إياهم إلاهيته بالآيات الدالة عليها والتعريف
قد يكون بالقول تارة وقد يكون بالفعل أخرى والتعريف بالقول قد يكون
إخباراً عن صدقه كقوله تعالى للملائكة " إني جاعل في الأرض خليفة " وقد
يكون تنبيهاً على صدقه بتعجيز الخلق عن معارضته كما علم آدم الأسماء كلها
ثم عرضهم على الملائكة وكما علم المصطفى القرآن وقال " فأتوا بسورة من
مثله " فكما عجزت الملائكة عن معارضة آدم بالأسماء عجزت العرب والعجم عن
معارضة المصطفى بآيات القرآن ودلت الأسماء والآيات على صدق النبي الأول
والنبي الآخر ولما ثبت صدق الأول كان مبشراً بمن بعده إلى الآخر ولما ثبت
صدق الآخر كان هو مصدقاً لمن قبله إلى الأول فكانت الأقوال متواصلة
والعلوم متواترة والكلمات متفقة والدعوات متحدة والكتب والصحف متصادقة
والسيوف على رقاب المنكرين قائمة ومن اصطفاه الله عز وجل لرسالته من عباده
واجتباه لدعوته كساه ثوب جمال في ألفاظه وأخلاقه وأحواله ما يعجز الخلائق
عن معارضته بشيء من ذلك فيصير جميع حركاته معجزة للناس كما صارت حركات
الناس معجزة لمن دونهم من الحيوانات ويكون مستتبعاً جميع نوع الإنسان كما
صار الإنسان مستسخراً جميع أنواع الحيوان " والله يصطفي من الملائكة رسلاً
ومن الناس رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل "
ونعيد ما أبديناه آنفاً.
فنقول أنتم معاشر الصابئة والبراهمة المعولون
على مجرد العقول وقضاياها وافقتمونا ولم يحتج بالموافقة بل قام الدليل
الواضح على أن لله تعالى تصرفاً في عباده بالتكليف والأمر وعلى حركاتهم
بالإحكام والحدود ومن القضايا العقلية أن نوع الإنسان يحتاج إلى اجتماع
على نظام وصلاح وإن ذلك الاجتماع لن يتحقق إلا بتعاون وتمانع وإن ذلك
التعاون والتمانع لن يتصور إلا بحدود وأحكام وإن تلك الحدود والأحكام تجب
أن تكون موافقة لحدود الله وأحكامه وإن كل من دب ودرج ليس يتلقى من الله
حدوده وأحكامه ولا له أن يضع من عند نفسه حدوداً وأحكاماً فلزم العقل
ضرورة أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يتلقى من الله وحياً وينزله
تنزيلاً على عباده وهذه قضايا عقلية بيننا وبينكم وإنما حقيقة القول إيل
إلى تعيين الشارع.
فنقول لن يتحتم على الله تعالى تعريف صدق من اصطفاه
لرسالته وتعيين شخص من اجتباه لشريعته فإنه يؤدي إلى التعجيز وإلى تكليف
ما لا يطاق وهو كما لو كلف عباده بمعرفته ثم يطمس عليهم وجوه أدلته وإذ لا
طريق إلى التصديق إلا بالقول والفعل ولا طريق إلى ذلك بالقول تعين الفعل
ولربما يعرف الملائكة بالقول ويعرف الناس بالفعل ولربما يعرف النوعين بهما
جميعاً أعني تعريفهما بفعل نازل منزلة القول أو بقول دال دلالة الفعل وليس
ذلك التعريف إيجاباً عليه تعالى وتقدس بل وجوباً له حتى لا يؤدي إلى
التعجيز في نصب الأدلة وحتى لا يفضي إلى التكذيب في خبر الاستخلاف وحتى لا
يكون على الله حجة بعد الرسل بتكليف ما لا يطاق فيقال " ربنا لولا أرسلت
إلينا رسولاً " وإذا أرسلت فهلا بنيت لنا طريقاً ودليلاً يتوصل به إلى
صدقه ويتوصل بتصديقه إلى معرفتك وطاعتك.
وقولكم أن الرسول يحيل نزول
الآية إلى مشيئة الله تعالى قلنا تلك الحوالة من أدل الأدلة على صدق
المقالة إذ لو ادعى الاستقلال بإظهار الآيات ما كان مخبراً عن الله تعالى
بأمره ولا داعياً إلى الله بإذنه فهو في كل حال من الأحوال يثبت حق موكله
ويظهر العجز من نفسه ويحيل الحول والقوة إلى مرسله وكان الفصل الذاتي لنفس
النبي عليه السلام أن لا يكون موكولاً لنفسه طرفة عين فلا ينطق عن الهوى
ولا يتحرك إلا على متن الهدى وذلك هو العصمة الإلهية المقيمة لنفسه
المقومة لذاته ولئن كان النطق فصلاً ذاتياً لنوع الإنسان " فما ينطق عن
الهوى إن هو إلا وحي يوحى " فصل ذاتي لنفس النبي عليه السلام أعرف الإشارة
ولا تؤاخذني بالعبارة ونقول أنتم معاشر الصابئة سلمتم بنبوة عاذيمون وهرمس
وهما شيث وإدريس عليهما السلام فبم عرفتم صدقهما أبمجرد الدعوى والخبر أم
بدليل ونظر وكل ما قدرتموه دليلاً في حق شخص واحد ثبتت به نبوته أو على
الجملة صدقه في جميع أقواله فهو دليل المخبر الثاني والثالث وإن أحلتم
الرسالة في الصورة البشرية فهما بشر مثلكم وأنتم مخبرون عنهما بشر مثلنا.
فإن
قلتم أنهما كانا حكيمين عالمين لا نبيين مرسلين قيل وبم وجب عليكم
اتباعههما والمحافظة على حدودهما وإحكامهما وانتهاج مناهجهما في الدعوات
والصلوات والصيام والزكوات وقد تساوت أقدامكم في العقول والأنفس وتشابهت
صوركم في البشرية والإنسانية.
ومن عجب ما يلزم منكري النبوة أن من أنكر
النبوة فقد أقر بها من حيث أنكرها فإن النبوة لا معنى لها إلا الخبر عن
الله تعالى بأنه أرسل رسولاً ومن أنكر فقد ادعى أنه مخبر عن الله أنه لم
يرسل رسولاً فقد ادعى الرسالة لنفسه فكان إنكاره إقراراً وعاد إنكاره
تسليماً ومن سلم أن لله على عباده تكليفاً وأمراً فقد سلم أنه يرسل رسولاً
وإنما النزاع وقع في أن الرسالة هل تتصور في الصورة البشرية " وما منع
الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً "
وإذا بينا أن البشرية لا تنافي الرسالة فقد أثبتنا جواز انبعاث الرسل
والصابئة سلموا الرسالة للروحانيات وأوجبوا التوجه إلى هياكلها من الكواكب
السبعة وعملوا الأشخاص على صورة الهياكل فتقربوا إليها وذلك عود إلى
الصورة والأصنام والحنفاء سلموا الرسالة للجسمانيات وأوجبوا التوجه إلى
أشخاصهم ولم يتخذوا أصناماً آلهة ولا اعتقدوا النبيين أرباباً لكنهم قالوا
لهم طرفان بشرية ورسالة " قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً " فبطرف
البشرية يشاكل نوع الإنسان ويشاركه فيأكل ويشرب وينام ويستيقظ ويحيى ويموت
وبطرف الرسالة يشاكل نوع الملائكة ويشاركه فيسبح ويقدس ويبيت عند ربه
فيطعمه ويسقيه وتنام عيناه ولا ينام قلبه ويموت قالبه ولا يموت روحه
والمناظرة بين الفريقين في أول الزمان كانت قائمة وقد أظهرها الخليل صلى
الله عليه وسلم حيث قال " إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر
السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين " وبذلك أمر خاتم النبيين عليه
السلام قال علي ملة أبيكم إبراهيم وقال إني أمرت أن أكون أول من أسلم وقال
إني وجهت وجهي الآية وغيرها من الآيات وفيه فصول كثيرة ذكرناها في كتاب
الملل والنحل.
وأما الجواب عن مسئلة إمهال النظر وإفحام الأنبياء فإنما يلزم الإفحام على من قال بالمهلة ويجب على النبي إمهال النظر وذلك مذهب المعتزلة وأما من قال بأنه لا يمهله ولا يجب عليه أن يمهله بل يجيب بأني جئت لأرفع المهلة وأرشدك إلى معرفة المرسل بأن أخبر عنك بما لا يمكنك إنكاره وهو احتياجك إلى صانع فاطر حكيم إذ كنت تعرف ضرورة أنك لم تكن فكنت وما كنت بنفسك بل بكون غيرك وهذه هي ابتداء الدعوة بيا " أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون " فكيف يمهله ويكله إلى نفسه وهو مأمور بدعوة الناس إلى التوحيد والمعرفة حالة فحالة وشخصاً فشخصاً والاستمهال إنما يتوجه إذا خلت الدعوة عن الحجة الملزمة والدلالة المفحمة فإن من تحققت رسالته عنه في نفسها وتصدى لدعوة الناس إلى وحدانية الله تعالى لا يخلى دعوته عن الدلالة على التوحيد أولاً ثم يتحدى بالرسالة عنه ثانياً اعتبر حال جميع الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم أما آدم أبو البشر فقد ثبت صدقه بإخبار الله تعالى ملائكته " إني جاعل في الأرض خليفة " فلم يكن في أول زمانه من كان مشركاً فيدعوه إلى التوحيد وحين أمروا بالطاعة فمن صدق الله تعالى في خبره فسجد له بأمره ومن لم يسجد فكأنه لم يصدق فاستحق اللعنة وهو أول من كفر وأما نوح عليه السلام فأول كلامه مع قومه " أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره " فأثبت التوحيد ثم النبوة فقال " أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم " وأما هود بعده فقال " يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره " ثم قال " ولكني رسول من رب العالمين " أثبت التوحيد ثم النبوة أما صالح بعده قال " يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره " ثم قال " قد جاءتكم بينة من ربكم " وأما لوط فإنه كان يدعو الناس بدعوة الخليل وما جرى بينه وبين قومه من عبدة الأوثان والكواكب من أظهر ما يتصور " وقال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون " وقال لأبيه آزر " أتتخذ أصناماً آلهةً يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً " ثم أثبت الرسالة فقال " يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً " وكانت الدعوة جارية على لسان أولاده إلى زمن موسى عليه السلام وكان من شأنه مع فرعون ما كان إذ قال له فرعون وما رب العالمين فمن ربكما يا موسى حتى حقق عليه التوحيد بتعريف وحدانيته استدلالاً من أفعاله عليه في جواب وما رب العالمين قال رب السموات والأرض وما بينهما وفي جواب من ربكما قال " ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى " ثم قال بعد ما قرر التوحيد " إني رسول من رب العالمين " فمن كان منكراً للتوحيد وجبت البداية معه بإثباته ومن كان مقراً به وجبت به البداية معه بإثبات النبوة كحال عيسى مع بني إسرائيل إذ قال " قد جئتكم ببينة من ربكم " ولما كانت دعوة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم أكمل ورسالته أرفع وأجل كان يبتدئ تارة مع عبدة الأصنام بإثبات التوحيد ثم بالنبوة " يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم " أثبت احتياجهم ضرورة إلى فاطر وشاركهم في ذلك من قبلهم والذين من قبلكم كما قرر احتياجهم إلى الخالق في وجودهم قرر احتياجهم إلى رازق في بقائهم " الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً " الآية ثم قرر بعد ذلك نبوته " وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله " الآية بمعناها دالة على التوحيد وبظاهر لفظها البليغ ونظمها الأنيق دالة على صدق دعواه وتحديه ولربما يبتدئ بدعوى الرسالة ثم يضمنها حقائق التوحيد " يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت " الآية حتى كانت الآية بعذوبة ألفاظها ورطوبة عباراتها الخارجة عن نظم الشعراء ونثر الفصحاء الخارقة لعاداتهم الجارية وعباراتهم الفائقة أوضح دلالة على رسالته وصدق لهجته وكانت معانيها الحقيقية وحقائقها المعنوية دالة على التوحيد واقترنت الدلالتان اقتراناً لا يمكن للمستمع الاستمهال وليس ذلك أمراً بالتقليد فإن التقليد قبول قول الغير من غير حجة وفيها تقرر حجتان مفحمتان وإنما لم يلزم تكليف ما لا يطاق إذا لم يكن المستمع متمكناً من الاستماع والنظر والتدبر في كل ما يستمعه ويعقله حتى لو أنكره ظهر عناده وبطل استرشاده هذا هو طريق الدعوة النبوية والحجة
العقلية
لا كما زعمت المعتزلة أن المستمع إذا استمهل وجب على النبي إمهاله فيلزمهم
أن لا تثبت لنبي ما رسالة ولا يستمر لرسول ما دعوة فإن كل عاقل إذا استمهل
وأمهل تعطلت النبوة في الحال وصار منتظراً مدة الإمهال حتى يعود إليه
الدعوة وإن يلزم العود إليه وبعد لم تثبت عنده نبوته بل يعود جبريل عليه
السلام ويقول قم فأنذر فيقوم إلى المستجيب فيقول أنت أمهلتني وأنا بعد في
مهلة النظر والنظر طريق المعرفة فتريد تصدني عن الطريق فأنت قبل معرفتي من
أنت مضل ضال قاطع للطريق فيتخاصمان ويقتتلان ويؤول الإلزام إلى النبي
قولاً وفعلاً فيلزم المعتزلة القول بأن أول واجب على العاقل قتال النبي
عليه السلام وقتله وهذا مما لا محيص لهم عنه.لعقلية لا كما زعمت المعتزلة
أن المستمع إذا استمهل وجب على النبي إمهاله فيلزمهم أن لا تثبت لنبي ما
رسالة ولا يستمر لرسول ما دعوة فإن كل عاقل إذا استمهل وأمهل تعطلت النبوة
في الحال وصار منتظراً مدة الإمهال حتى يعود إليه الدعوة وإن يلزم العود
إليه وبعد لم تثبت عنده نبوته بل يعود جبريل عليه السلام ويقول قم فأنذر
فيقوم إلى المستجيب فيقول أنت أمهلتني وأنا بعد في مهلة النظر والنظر طريق
المعرفة فتريد تصدني عن الطريق فأنت قبل معرفتي من أنت مضل ضال قاطع
للطريق فيتخاصمان ويقتتلان ويؤول الإلزام إلى النبي قولاً وفعلاً فيلزم
المعتزلة القول بأن أول واجب على العاقل قتال النبي عليه السلام وقتله
وهذا مما لا محيص لهم عنه.
وأما الجواب عن ردهم الخوارق إلى الخواص
والتنجيم وعلم السحر والطلسمات قلنا لا ينكر العاقل حصول العجائب من
الخواص والعزائم لكن أمثال هذه الغرائب ليست تخلو قط عن حيل كسبية تنضاف
إليها من مباشرة فعل وجمع شيء إلى شيء واختيار وقت وتعزيم قول وإعداد آلة
واستعداد مادة وبالجملة من مزاولة فعل وقول من جهة المدعي بحيث يتبين
للناظر أن ذلك ليس فعلاً لله تعالى أنشأه في الحال تصديقاً لدعوته بخلاف
المعجزة فإن كل عاقل يعلم بالضرورة أن عظاماً رفاتاً رماماً تجتمع فتحيا
شخصاً وتتشخص حياً من غير معالجة من جهة المتحدي ولا مزاولة أمر عنه لا
يكون ذلك إلا فعلاً وصنعاً من الله تعالى يظهر منه قصده إلى تصديق رسوله
فإنا قد ذكرنا أن الفعل بتخصيصه ببعض الجائزات يدل على إرادة الفاعل فإذا
فعله عقيب دعوته مقترناً بدعواه وهو صادق في نفسه دل على قصده إلى تصديقه
وتخصيصه لرسالته ولو قدر ظهور مثل تلك المعجزة على يد كاذب لم يجز أن
تقترن بدعواه النبوة بل يصرف عنه داعيه الدعوى ضرورة حتى لا ينقلب الدليل
شبهة ولا ينسحم الطريق على قدرة الله تعالى في إظهار التصديق بالآيات وكما
إذا اختص الفعل بوقت وقدر وشكل دل على إرادة مخصصة بذلك الوقت والقدر
والشكل ولن يقدر وقوعه اتفاقاً كذلك إذا اختص الفعل بوقت تحدي المتحدي دل
ذلك على أنه إنما أراد تخصيصه بالصدق وكما لم يختلف وجه الدليل على وجه
تعلق الإرادة بتخصيص التصديق فافهم هذه الدقيقة هذا كمن علم أن له عند
الله دعوة مستجابة فدعا واستجيب له علم ضرورة أن المجيب أراد تخصيصه بتلك
الإجابة كرامة له وإنعاماً عليه ولم يقدح في علمه ذلك تجويز المجوز أن ذلك
ربما يقع اتفاقاً أو بسبب آخر فإذا كان مثل ذلك معلوماً في الجزيات لكل
شخص شخص عرف مواقع نعم الله تعالى على عبده وكان بصيراً بزمانه مقبلاً على
شأنه فما ظنك بحال من اصطفاه الله تعالى من خليقته واجتباه من بريته وقد
تبين أنه يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم.
قال المنكرون ولنا أسئلة أخرى وجب عليكم الجواب عنها
منها
أن الخارق للعادة إذا تكرر وتوالى صار معتاداً بالاتفاق فما يؤمنكم في
الحالة الأولى أنه من المتكررات المعتادة في ثاني الحال وإن لم يوجد في
سابق الأحوال ألستم تشترطون أن يكون الخارق في زمن التكليف فإن في آخر
الزمان تنخرق العادات كلها فتتكور الشمس وتتكدر النجوم وتسير الجبال وتنشق
السماء وتزلزل الأرض فلو ادعى مدع أن هذه وأمثالها معجزاتي وهي بالاتفاق
خوارق لا تندرج تحت قوة البشر ولا يتوصل إليه بالحيل بل تمحضت فعلاً لله
تعالى فلا يكون ذلك دليلاً على دعوى هذا المدعي فالعاقل في زمن التكليف
ربما يتوقع أن تتوالى الآيات فلا يحصل له العلم بكونها آية على صدقه ما لم
يأمن التوالي والتعاقب بل يورثه ذلك توقفاً وتربصاً.
ومنها أن العقلاء
كما يجوزون وقوع أمثاله في ثاني الحال كذلك يجوزون وقوع أمثاله في سالف
الأيام أو في قطر آخر من الأقطار أو ظهور ذلك بفعل فاعل آخر وإن كانوا
عاجزين عن معارضته فربما لا يعجز غيرهم فعجزهم لا يدل على صدقه.
ومنها
أن الشك في صدقه لكل واحد من الناس فيجب أن يكون الرافع للشك لكل واحد
واحد وعلى مقتضى ذلك يلزم أن يخصص كل واحد أو كل جمع غيب أو حضور بمعجزة
خاصة وليس ذلك شرطاً على أصلكم بل عندكم المعجزة الواحدة لجماعة من أهل
الخبرة والبصيرة كافية ويلزم التصديق على غيرهم من أهل التقليد ولا يجب
استمرار المعجزة في كل زمن بل لو استمرت خرجت عن الإعجاز والتحقت بالمعتاد
فماذا يلزمنا تصديق الأنبياء الماضين ولم نجد في زماننا ما يدل على صدقهم
وبما يلزم أهل الأقطار في زمانه ولم يشاهدوا ما ظهر على يده من الآيات
وهذا مشكل.
ومنها أنكم إذا جوزتم الإضلال على الله تعالى فما يشعركم
أنه يظهر الآيات على يدي كاذب ولا يظهرها على وفق صادق فلا ذلك يضره في
الإلهية ولا هذا ينفعه في الربوبية وكثير من الأنبياء قد خلت دعوتهم من
المعجزة فمضوا على أمر الله دعاة للخلق من غير التفات إلى طلب الآيات منهم
ومن غير إكباب على طلب الآيات من الله تعالى فما بالكم ربطتم صدق الرسول
بالمعجزات هذا الربط.
ومنها قولهم هل للخلق طريق إلى معرفة صدق الرسل
سوى المعجزات الخارقة للعادات فإن منعتم ذلك فقد حصرتم القول وحسمتم
الطريق على الله تعالى وذلك تعجيز وإن جوزتم ذلك فهلا وجب ذلك وجوب
المعجزة فما الذي جعل المعجزة أولى بالدلالة من ذلك الدليل.
ومنها
قولهم أنكم لا تخلون عن دعوى علم ضروري في وجه دلالة المعجزة فتارة تدعون
الضروري من حيث القرينة الحالية وهي اقتران التحدي بالمعجزة وتارة تدعون
ذلك من حيث دلالتها على قصد المخصص إلى التخصيص وتارة تدعون ذلك من حيث
أنها نازلة منزلة التصديق بالقول وتارة تدعون ذلك من حيث سلامتها عن
المعارضة فهلا ادعيتم الضرورة في أصل الدعوى أنه يعلم صدقه ضرورة.
ولئن
قلتم أن قوله خبر يحتمل الصدق والكذب فيقال لكم والاحتمالات تتوجه إلى هذه
الوجوه أيضاً فبطل دعواكم الضرورة فيها خصوصاً والمنازع فيها على رأس
الإنكار " وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر " " وما تأتيهم من آية
من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين " ما نسبتهم إلى العناد الصرف نسبوك
إلى الجور المحض فما وجه الخلاص ولات حين مناص.
قال أهل الحق أما
الجواب عن السؤال الأول أن المعتاد إنما لم يكن دليلاً لأنه لا اختصاص له
بدعوى المدعي وغير المعتاد يختص بدعواه اختصاص دلالة أما من حيث القرينة
كحمرة الخجل وصفرة الوجل وأما من حيث أن اختصاص الفعل بدعواه كاختصاصه
بوقت معين ثم اختصاصه بوقت معين دليل قصد المخصص بالوقت واختصاصه بدعواه
دليل قصد المخصص إلى التصديق والوجهان حاصلان بنفس الاقتران ولو توالى
الخارق بعد ذلك لم ترتفع هذه الدلالة فإن اعتياده في ثاني الحال لم يرفع
القرينة الأولى ولا أبطل الاختصاص الأول وقال بعضهم المعجزة كما سلمت عن
المعارضة تسلم عن الاعتياد في ثاني الحال ولهذا لم يعهد من معجزات
الأنبياء ما كان خارقاً في الأول ثم صار معتاداً في الثاني الحال وإنما هو
إلزام تجويزي عقلي فيندفع بما ذكرناه منعاً للإلزام.
وأما الجواب عن
السؤال الثاني فهو يقارب ما ذكرناه من تحقيق وجه دلالة المعجزة وبالجملة
التجويزات الخيالية والوهمية مدفوعة بالدلائل العقلية والقرائن القطعية
وقد قررنا أن المعجزة ذات دلالة عقلية وهو اختصاصها بتحدي المدعي واقتضاء
الاختصاص قصداً إلى التخصيص وجواز حصول مثل ذلك في قطر من الأقطار أو في
وقت من الأوقات لا تخرج الدلالة عن كونها دالة لأنه لم يوجد اقتران يدل
على الاختصاص واختصاص يدل على قصد التصديق والمعجزة أيضاً ذات دلالة من
حيث القرينة وجواز حصول مثله لا يرفع دلالة القرينة كمن عرف قطعاً بحكم
قرينة اطراد العادة أن ماء الفرات لم ينقلب دماً عبيطاً وهو جار جريانه في
الأول مه أنه يجوز عقلاً أو وهماً من قضية قدرة الله تعالى أنه قلبه دماً
جارياً أو يبس النهر عن الجريان وهذا التجويز لا يدفع العلم الضروري وكذلك
يجوز عقلاً أن تكون الصفرة في الوجه غير دالة على الوجل لكن إذا اقترنت
بها حال وسبب للوجل علم ضرورة أنها صفرة الوجل لا صفرة المرض.
ونقول
نعلم ضرورةً أن الصعود إلى السماء والمشي على الماء وإحياء الموتى وقلب
العصا حية تسعى وأمثال ذلك نقض لعادة البشر فإذا اقترنت بتحدي الرسالة أو
تصديق قول ما كانت آية وحجة على البشر وإن لم تكن نقضاً لعادة الملائكة
والجن والمعتبر في كون الآية حجة أن يكون ذلك نقضاً لعادة من كانت الآية
حجة عليه والعادة عادة له وكذلك لو ادعى النبي مداً وجزراً في جيحون كان
ذلك حجة لأنه نقض لعادتها وإن كان معتاداً لأهل البصرة وكذلك لو قال آية
صدقي أن ينبت الله نخيلاً بخراسان كان ذلك آية معجزةً له.
وأما الجواب
عن السؤال الثالث أن نقول كل من عارضه شك في صدق المتحدي وجب إراحته لكن
المعجزة إذا ظهرت لأهل الخبرة وحصل لهم العلم بذلك وهو جم غفير فأخرى أن
لا يبقى شك لأهل الصناعات الأخر وإن أشد الناس إنكاراً من كان عنده خبرة
وبصيرة بخواص الأشياء وأحوال أهل المخرقة والتخيل وإذا ظهرت المعجزة على
خلاف ما توهموه فهو أولى الناس بالقبول وأما العامة فالتخيلات والمخاريق
إذا أورثت لهم شكاً في الحال فأولى أن لا يعتريهم ريب في مقال أصحاب
المعجزات فيلزمهم الإقرار بتصديقه ويلزم غيرهم من العامة إذا سمعوا منهم
جلية الأمر الاعتراف به من غير توقف ولا ريب ولا يجب على النبي عليه
السلام تتبع آحاد الناس وإفراد كل واحد بمعجزة خاصة وإذا تقرر صدقه فنسبة
قوله إلى من صح عنده كنسبته إلى غيره إما في زمانه وهو في قطر آخر
باستفاضة الخبر إليه والمواترة عليه وإما في غير زمانه بالنقل والاستفاضة
والشيوع.
وأما الجواب عن السؤال الرابع نقول نحن نجوز الإضلال على
الله تعالى ولكن بشرط أن لا يقع خلاف المعلوم وبشرط أن لا يتناقض الدليل
والمدلول ولا يلتبس الدليل والشبهة وبشرط أن لا يؤدي الأمر إلى التعجيز
وبشرط أن لا يؤدي إلى التكذيب في القول ونذكر لكل واحد وجهاً ومثالاً
فنقول إذا علم الرب تعالى أنه يرسل رسولاً يهتدي به قوم فهو كما يعلم أنه
ينصب دليلاً يستدل به قوم فلو أضلهم بعين ذلك الدليل وقع الأمر على خلاف
المعلوم وذلك محال وكذلك إذا أخبر أنه يرسل رسولاً يهتدي به ثم أضل كل من
بعث إليه تناقض الخبر وانقلب الصدق كذباً وذلك محال فإن الكذب لا يجوز على
الله تعالى وإنما لا يجوز ذلك عليه لأن الكذب إخبار عن الشيء على خلاف ما
هو به وهو يعلمه على ما هو به وكل من علم شيئاً كان له خبر عن معلومه
والخبر عن المعلوم خبر عن ما هو به فلا يجتمع في العالم خبران متناقضان
وإذا علم الرب تعالى صدق النبي وأخبر عن صدقه فقد صدقه ومن صدقه فلا يجوز
أن يكذبه ومن وجه تناقض الدليل أن جهة الدلالة في القرينة وفي الفعل لا
تختلف فإذا دل الشيء على شيء لا يجوز أن يدل على خلافه فإن ذلك غير مقدور
كما أن جهة التخصيص إذا دلت على الإرادة لم تدل على خلاف ذلك فجهة التخصيص
بالتصديق لا تدل على خلاف قصد المخصص بالتصديق فإرسال رسول وإخلاؤه عن
دليل الصدق وإظهار معجزة والقصد بها إلى إضلال الخلق وإظهار خارق للعادة
على يدي كاذب في معارضة دعوى النبي كل ذلك محال لما ذكرناه أنه يؤدي إلى
محال كإخلاء النظر الصحيح التام عن الإفضاء إلى العلم فإنه إذا تم وجب
وجود العلم لا محالة وكنصب دلالة التوحيد لتدل على الشرك والإضلال على
الإطلاق يجوز أن يضاف إلى الله تعالى بمعنى أنه يخلق ضلالاً في قلب شخص
لكنه إذا أدى إلى محال فهو محال فلا يفعله لتناقضه واستحالته ولا لقبحه
وبشاعته.
وأما الجواب عن السؤال الخامس نقول لا ينحصر طريق التعريف في
المعجزات بل يجوز أن يخلق لهم علماً ضرورياً بصدق النبي فلا يحتاج المذكر
إلى طلب المعجزة ليعرف بها صدقه أو ينصب لهم إمارات أخر غير خارقة للعادة
لكن يتبين لواحد بحكم قرينة أورثت علماً لشخص ولم تورث علماً لغيره أو
يخبر من استأهله لسماع كلامه فيعلم صدقه كما أخبر الملائكة " إني جاعل في
الأرض خليفة " وإذا ثبت صدقه عندهم إما بالخبر أو بتعليم الأسماء لزم
تصديقه على كل من خلف بعدهم وإذا أخبر من ثبت صدقه بدليل ما عن صادق آخر
يخلفه وجب تصديقه وكذلك الخبر عن كل صادق بشارة لمن بعده وإعلاماً للخلق
بآيات في خلقه وصورته وقوله وفعله وجب على كل من سمع ذلك تصديقه بإخبار
الأول ولهذا أخبر التنزيل عن مثل هذه الحالة على لسان عيسى عليه السلام "
ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد " وعلى لسان موسى عليه السلام "
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل " الآية وعلى
لسان الخليل عليه السلام " ربنا وابعث فيهم رسولاً " الآية وأماراته في
التوراة والإنجيل أكثر من أن تحصى ولقد كان لموسى عليه السلام بيت صور
أعني صور الأنبياء والأولياء عليه السلام يدخله فيطالع الصور كل سبت فلو
لم يظهر النبي معجزة قط كان ما مضى من الدلائل كافياً له فلهذا اقتصرت
معجزاته على إظهار الأمر للأميين من العرب دون أهل الكتاب من اليهود
والنصارى فإنهم كانوا محجوبين بما ثبت عندهم من الأخبار عن الصادقين.
وأما
الجواب عن السؤال السادس نقول كل علم نظري لا بد وأن يستند إلى علم ضروري
ولكن الضروري ربما يكون بعيد المبدأ وإنما يستند إليه النظري بعد نظريات
كثيرة وربما يكون قريب المبدأ فيستند إليه في أول المرتبة والعلم بصدق
النبوات إن عددناه من جنس العلوم الحاصلة بقرائن الأحوال فهو في أول
المرتبة يصل إليه فيقال هذا المتحدي إما أن يكون صادقاً وإما أن يكون
كاذباً وبطل أن يكون كاذباً لحصول الخارق للعادة على يده وعلى وفق دعواه
من غير أن يعارضه معارض واقتران هذه المعاني مما يستعقب علماً ضرورياً
بصدقه فيدعي الضرورة ها هنا لا في أول الدعوى وإن عددناه من جنس العلوم
الحاصلة بوجه دليل التخصيص بالتصديق فالعلم الحاصل به كالعلم الحاصل بكونه
مريداً فإن التخصيص يدل على أنه مريد وهذا التخصيص بعينه يدل على انه مريد
هذا المراد بعينه وكون المنازع على رأس الإنكار لا يدفع الضرورة الواقعة
في العلم فإنه بعد ظهور الآية معاند عناداً ظاهراً واعلم أن النبوة
والرسالة إنما يمكن إثباتها بعد إثبات كون الباري تعالى آمراً ناهياً
مكلفاً واجب الطاعة ومن لم يثبت كونه آمراً ناهياً لم يمكنه إثبات النبوة
وأول أمر يتوجه منه تعالى على عباده فإنما يتوجه أولاً على رسوله بالدعوة
إلى التوحيد بأنه لا إله غيره أي لا خالق ولا آمر غيره على عباده باستماع
دعوته والنظر في معجزته والنبي يصح أولاً صدقه في جميع أقواله ثم يؤدي
رسالته ولا يتصور نبي قط إلا وأن تكون آية الصدق معه لأن حقيقة النبوة هو
صدق القول مع ثبوت الآية فلو قدر نبي خالياً عن الآية فكأنه لا نبوة له
بعد لكن الآيات قد تكون آيات مخصوصة على كل مسئلة وقول يدعي ذلك وذلك مثل
دلالته على التوحيد بأن الإله واحد في خلقه وأمره لا شريك له وقد تكون
الآيات عامة تدل على صدق قوله في جميع أقواله وأحواله وتلك الآيات قد تكون
من جنس الأقوال كآيات الإحياء وقلب الجماد حيواناً وبالجملة فدلالة الصدق
لا تنفك عن حالة ومقالة طرفة عين وذلك هو المعنى بالعصمة الواجبة للأنبياء
عليه السلام لأن العصمة لو ارتفعت بطلت الدلالة وتناقضت الدعوى خصوصاً
فيما أرسلوا به إليهم وكلف الناس تصديقه في أقواله ومتابعته في أفعاله
والأصح أنهم معصومون عن الصغائر عصمتهم عن الكبائر فإن الصغائر إذا توالت
صارت بالاتفاق كبائر وما أسكر كثيره فقليله حرام لكن المجوز عليهم عقلاً
وشرعاً مثل ترك الأولى من الأمرين المتقابلين جوازاً وجوازاً وحظراً
وحظراً ولكن التشديد عليهم في ذلك القدر يوازي التشديد على غيرهم في كبائر
الأمور وحسنات الأبرار سيئات المقربين وتحت كل زلة يجري عليهم سر عظيم فلا
تلتفت إلى ظواهر الأحوال وانظر إلى سرائر المآل.
القاعدة العشرون
في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وبيان معجزاته ووجه دلالة الكتاب العزيز على صدقه وجمل من الكلام في السمعيات من الأسماء والأحكام وحقيقة الإيمان والكفر والقول في التكفير والتضليل وبيان سؤال القبر والحشر والبعث والميزان والحساب والحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار وإثبات الإمامة وبيان كرامة الأولياء من الأمة وبيان جواز النسخ في الشرائع وأن هذه الشريعة ناسخة للشرائع كلها وأن محمداً المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وبه ختم الكتاب وإذا حققنا القول في النبوات وبيان صدقهم بالمعجزات فالأنبياء عليهم السلام ممن ورد اسمه في الكتاب ومن لم يرد واجبو الطاعة ويجب على كل مكلف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وإنما ثبت صدق من تقدم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسماً فاسماً وشخصاً فشخصاً بما ظهر عليه من الآيات وبما أخبر من ثبت صدقه عندنا وإنما يتحقق ختم الأنبياء عندنا بخبر النبي الصادق عليه السلام وبما أخبر القرآن أنه خاتم النبيين ومن أنكر نبوته من أهل الكتاب وغيرهم من المشركين فلا متمسك لهم إلا القول بإحالة النسخ والقدح في وجه المعجزة.قال أهل الحق الدليل على صدق نبينا عليه السلام الكتاب الذي جاء به هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان ووجه دلالته على صدقه من حيث لفظه البليغ ومعناه المبين فنقول كما تميز نوع الإنسان عن أنواع الحيوانات بالنطق المعبر عن الفكر وصار ذلك شرفاً وكرامةً له كما قال تعالى " ولقد كرمنا بني آدم " كذلك تميز لسان العرب ولغتهم من سائر الألسن واللغات بأسلوب آخر من عذوبة اللسان ورطوبة اللفظ وسهولة المخارج والتعبير عن متن المعنى الدائر في الضمير بأوضح عبارة وأصح تفسير وصار ذلك شرفاً وكرامةً لهم كما قال تعالى " بلسان عربي مبين " وكذلك تميز لسان النبي صلى الله عليه وسلم من لسان العرب بأسلوب آخر من الفصاحة المبينة والبلاغة الفائقة والبراعة المطابقة لما في ضميره من المعاني المبينة والحقائق الرزينة كما لا يخفى على من أنصف واعتبر واختبر كلماته واستبصر وصار ذلك شرفاً وكرامة كما قال " لتبين للناس ما نزل إليهم " وقال النبي صلى الله عليه وسلم " أنا أفصح العرب وأنا أفصح من نطق بالضاد " وكذلك تميز القرآن عن سائر كلماته بأسلوب آخر خارج عن جنس كلام العرب وعن كلماته أيضاً وبنوع آخر من الفصاحة والجزالة والنظم والبلاغة ما لم تعهده العرب في نظمهم ونثرهم وسجعهم وشعرهم بحيث لو قوبل أفصح كلماتهم بسورة واحدة من القرآن كان التفاوت بينهما أكثر من التفاوت بين لسان العرب وبين سائر الألسن ولو خاير مخاير بين كلمات النبي نفسه وبين ما نزل عليه من الكتاب المهيمن على الكتب كلها كان الفرق بينهما فرق ما بين القدم والفرق والصرف بينهما صرف ما بين الولاية والصرف فعلم ضرورة وقطعاً أن الذي جاء به وحي يوحى إليه وتنزيل ينزل عليه دلالة له على صدقه ومعجزة له على فصحاء العرب وبلغاء أهل اللسان وشعراء ذلك الزمان فتحدى بذلك تحدي التعجيز عن الإتيان بمثله كتاباً وقرآناً " قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما " ثم ثنى ذلك فقال " فأتوا بحديث مثله " ولما عجزوا عن الإتيان بمثله نزل عن ذلك حين قال القوم إنه افتراه فقال " قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات " ونزل عن العشر إلى سورة مثله فقال تعالى " وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين " ولما ظهر عجزهم وبان خزيهم أنذرهم صاحب التنزيل وحذرهم المتحدي بالدليل " فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين " وكيف لا يكون التعجيز ظاهراً ظهور الشمس والكتاب يقرأ عليهم " قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن " الآية أفلم يكن بليغ من بلغاء العرب وفصيح من فصحائهم يتصدى لمعارضة هذه الدعوى العريضة الواسعة لنوعي الجن والإنس وقد خبروا بين معارضة القرآن والخروج بالسيف والسنان فكيف اختاروا الأشد على الأضعف وآثروا ما فيه بذل المهج والنفوس واستحلال النساء واسترقاق الأولاد واستباحة الأموال على أهون الأمور وأيسر ما في المقدور وهو معارضة سورة واحدة أفلا يكون ذلك عجزاً ظاهراً ونكولاً واضحاً وإن استراب في ذلك مستريب تشكيكاً لنفسه في مظان القطع واليقين وتسييعاً للغزالة بالطين فالنقد حاضر لم يبدل ولسان القرآن على رأس التحدي كما ورد في الخبر القرآن حي يجري كما يجري الليل والنهار ولسان المعارض عي عن المعارضة من مدة خمس مئة سنة وزيادة وبلغاء العرب قد اجتمعت لهم متانة الشعر في العصر الأول ولطافة الطبع من العصر الأخير أوَ لم يفدنا عجز الأولين والآخرين دلالة ظاهرة على أن مضمون القرآن حق وأن قول من أتى به صدق كيف ولو اعتبرت سورة بسورة اعتبار متأمل فيها منصف صادف كل سورة على حيالها اشتملت على صنف من الفصاحة وضرب من البلاغة والجزالة ولم تشاركها في ذلك سورة أخرى وربما تكون القصة واحدة والتعبير عنها مختلف اختلافاً لا يخل بالمعاني ويكون أسلوب النظم والبلاغة نوعاً آخر يباين الأولى واختبر هذا المعنى في قصة مثناة وبالخصوص في قصة موسى عليه السلام في سورة المص وقصته في سورة طه فمن ذا الذي يقدر على مثل ذلك من البشر وكيف يصل إلى غايته القوة المنطقية الإنسانية ولهذا لما فطنت البلغاء من العرب لبديع النظم والجزالة فيه قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر هذا من حيث اللفظ.
وأما من حيث المعنى
فما اشتمل عليه القرآن من غرائب الحكم وبدائع المعاني التي عجزت الحكماء
والأوائل عن الإتيان بمثلها نوع آخر من الإعجاز خصوصاً ممن نشأ يتيماً بين
الأميين من العرب ولم يقرأ كتاباً ولم يدرس علماً ولا تلقف من أستاذ ولا
تعلم من معلم فلولا أنه وحي محض يوحى عليه وتنزيل نزل إليه وإلا فمن أين
لطبع مجرد يجود بمثله وأيضاً فما يشتمل عليه القرآن من قصص الأنبياء
والمرسلين كيف جرت دعوتهم ومن أين أجاب كلمتهم ومن نكل عنهم إلى أي حال آل
أمرهم فمن لم يسمع ذلك من أحد ولا خط كتاباً بيمينه ولا طالع كتب الأنبياء
والتواريخ والأخبار معجز ظاهر ودليل على أن الحق باهر وهذا في قصة الماضين
فما قولك في الأخبار عن الغيوب مما سيكون في ثاني الحال مما رأيناه طابق
الحال وصدق المقال إذا أخبر أنه يظهره على الدين كله وقد أظهر وأخبر أنه
غلبت الروم وقد تحقق وغير ذلك من الأخبار وكذلك ما اشتمل عليه القرآن من
أنواع العبادات والمعاملات من أحكام الحلال والحرام والحدود والقصاص
والديات وأحكام السياسات إعجاز ظاهر إذ جمع فيها بين إصلاح المعاش ونجاة
المعاد وبناها على قوانين كلية تجمع شمل العامة وتناظر عقل الخاصة ومن قرأ
الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل والزبور تبين له الفرق الظاهر بينها
وبين القرآن إذ كل ما اشتملت عليه من الحقائق العقلية والأحكام الشرعية
على بسطها اشتمل عليه القرآن بأوضح عبارة وأوضح إشارة على اختصاصه ومن
أراد أن يتخطى عما أقررناه إلى مفردات الحروف وكيفيات تركيبها وما فيها من
الحكم والمعاني قضى منها العجب وبالجملة القرآن بصورة ألفاظه وعباراته
معجز وبمعنى حقائقه وعجائبه معجب وهو دليل ظاهر على حقيقة ذاته وصدق
المتحدي بآياته.
قال أهل الزيغ والباطل لنا على مساق ما ذكرتموه من
إعجاز القرآن سؤالان أحدهما أن القرآن بمعنى المقروء والمكتوب صفة قديمة
عندكم والقديم لا يكون معجزاً وبمعنى القراءة هو فعل القارئ وتلاوته وفعل
العبد لا يكون معجزاً.
فإن قلتم أن الرب تعالى يخلقه في الحال من غير
كسب النبي قيل وفي أي محل يخلقه أفي لسانه ومن المعلوم أن الحرف والصوت
القائم بلسانه ومخارج حروفه مقدورة له والمعجزة لا تكون مقدورة للعبد أم
في محل آخر من شجرة أو لوح أو قلب ملك فالمعجزة ذلك المخلوق لا ما نطق به
النبي فما هو معجزة لم نسمعه وما سمعناه ليس بمعجزة فما الجواب عن هذا
السؤال.
والثاني أنكم قلتم وجه إعجاز القرآن فصاحته وجزالته ونظمه
وبلاغته فما حدود هذه المعاني أولاً حتى نبين حقائقها فنتكلم عليها أهي
بإفرادها معجزة أم بمجموعها وقد رأينا كم اختلفتم في أن القرآن معجزة من
جهة صرف الدواعي أم من جهة ما اشتمل عليه من بديع النظم والفصاحة ومن قال
بالقسم الثاني اختلف في أن الفصاحة بديعة أم الجزاالة أم النظم ومن
المعلوم الذي لا مرية فيه أن المعجز يجب أن يكون ظاهراً لكل من هو في حقه
معجز ظهوراً لا يستراب فيه البتة ومن قال منكم أنه معجز من حيث الفصاحة
فقط جوز أن يكون في كلام العرب مثله من حيث النظم والجزالة ومن قال
بالثاني فقد جوز المماثلة في الأول فلم يظهر ظهور انقلاب الجماد حيواناً
والبحر يبساً والحجر الصلد عيناً نضاخة إلى غير ذلك من معجزات الأنبياء
عليهم السلام إذ ظهرت على قضية لم يبق للتردد فيها مجال.
قال أهل
الحق أما السؤال الأول فنقول القديم يستحيل أن يكون معجزة والمكتسب للعبد
كذلك وللقرآن وجوه من المعجزات ولكل وجه وجوه من التقديرات فيجوز أن يقال
أن التلاوة من حيث أنها تلاوة معجزة وتقدير الإعجاز فيها من وجهين أحدهما
أن يخلق الله تعالى هذه الحروف المركبة وتلك الكلمات المنظومة في لسان
التالي من غير أن يكون قادراً عليها ومحركاً لسانه بقدرته واستطاعته فتمحض
فعلاً لله تعالى ويظهر إعجازه في نظمه المخصوص ويجوز أن يخلق الله في نفس
النبي كلاماً منظوماً فيترجم عنه بلسانه ويكون تحريك اللسان مقدوراً له
لكن الكلام المعجز ما اشتمل عليه الضمير ونعت في الصدور كما قال تعالى "
ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه " أي في صدرك وقلبك فإذا
قرأناه أي جمعناه فاتبع قرآنه ويجوز أن يخلق الله ذلك الكلام في قلب الملك
أو في لسانه فيلقيه وحياً إلى قلب النبي ويعبر عنه النبي بلسانه كما قال
تعالى " إنه لقول رسول كريم " أي تنزيلاً ووحياً وكما قال " علمه شديد
القوى " ويجوز أن يكون قد خلق الله هذه العبارات المنظومة بعينها في اللوح
المحفوظ ليقرأ جبريل عليه السلام منه ويقرأها على النبي صلى الله عليه
وسلم فيسمع النبي منه كما لو يسمع الواحد منا ويكون المعجز هو الكلام
المنظوم وجبريل مظهر والنبي مظهر كما أن واحداً منا يقرأه ويكون مظهراً
لكن إظهار جبريل إظهارنا ليدل على صدق النبي عليه السلام وهذا كما خلق
الله تعالى الناقة في الصخرة ثم أظهرها منها عند دعوة صالح عليه السلام
فيكون إظهار المعجزة مقروناً بالدعوى والتحدي لا إظهار المعجز كخلق المعجز
في الدلالة على الصدق وينبغي أن ننبه ها هنا على هذه الدقيقة وهي أنا إذا
روينا شعر الشاعر فنحس من أنفسنا قدرة على التلفظ بذلك الشعر ولا نحس من
أنفسنا قدرة على نظم ذلك بل ربما يكون الراوي عديم الطبع في إنشاء الشعر
فضلاً عن نظم مخصوص فما المقدور منه وما غير المقدور فنقول إذا قرأنا
شعراً من كتاب أو سمعناه من لسان وحفظناه ارتسم الخيال في القلب والنفس
بذلك الشعر وتمكن منه ثم عبر بلسانه عنه فيكون المسموع والمحفوظ من حيث
أنه سمعه وحفظه مقدوراً له لكن النظم المرتب في المحفوظ والمسموع غير
مقدور له وهو كما لو ألقى من لا يعرف الكتابة أصلاً لوحاً منقوراً فيه سور
منظومة على تراب ناعم حتى انتقش بها نقشاً مطابقاً كان الإلقاء مقدوراً له
والنقش غير مقدور له إذ ليس يعرف الكتابة أصلاً فالارتسام في النفس
والخيال كالانتقاش في التراب سواء فيبقى نظم الشعر نقشاً بعد نقش زماناً
أبد الدهر وكذلك ارتسام قلب النبي من إلقاء القرآن إليه وحياً وتنزيلاً
كانتقاش التراب الناعم بالنقش المنقور في اللوح فيكون المرتسم قلبه
والمعبر عنه لسانه والرسم غير مقدور له بل تمحض ذلك ابتداعاً من الله
تعالى فهذا هو طريق وجوده معجزاً.
وعلى طريقة أخرى ظهور كلام الباري
تعالى بالعبارات والحروف والأصوات وإن كان في نفسه واحداً أزلياً كظهور
جبريل بالأشخاص والأجسام والأعراض وإن كان في نفسه ذا حقيقة أخرى متقدماً
على الشخص فإنه لا يقال انقلبت حقيقته إلى حقيقة الجسمية في شخص معين لأن
قلب الأشخاص محال وإن قيل انعدمت حقيقة ووجدت حقيقة أخرى فالثاني ليس
بجبريل فلا وجه إلا أن يقال ظهر به ظهور المعنى بالعبارات أو ظهور روح ما
بشخص ما فكما صارت العبارات شخص المعنى كذلك صارت صورة الأعرابي شخص الملك
وقد عبر القرآن عن مثل هذا المعنى " ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً "
فكذلك يجب أن تفهم عبارات القرآن.
الجواب عن السؤال الثاني فنحقق
أولاً حقائق الفصاحة والجزالة والنظم والبلاغة ونميز بين كل واحد منها ثم
نبين أن الإعجاز في كل واحد أو في المجموع فنقول أولاً قولاً على سبيل
المباحثة والبسط ليتضح الغرض والمعنى به ثم نقول قولاً ثانياً على سبيل
التحديد والضبط المنحصر الغرض والمعنى فيه اللفظ قد يكون دالاً على المعنى
دلالة مطلقة إما وضعاً وإما مجازاً وقد يكون دالاً على المعنى بشرط أن
يكون مفصحاً عن كنه حقيقته معبراً عن غرض المتكلم وإرادته والقسم الأول
مقل قولنا تحرك الجسم فإنه يطلق على حركة الجمادات والنبات والحيوان
والإنسان والسماء والأرض وكل ما هو قابل للحركة ثم إذا وضع اللفظ لموضوع
خاص عبر عن تلك الحركة بعبارة أخص كما ورد في القرآن " يوم تمور السماء
موراً وتسير الجبال سيراً " فإن المور أخص دلالة من السير وهما أخص من
الحركة وذلك أن المور حركة لطيفة لجسم لطيف وذلك كالشعاع يذهب شعاعاً
بخلاف السير فكان المور المضاف إلى السماء والسير المضاف إلى الجبال
مفصحاً عن متن الغرض مبيناً عن المعنى اللائق به وكان أفصح من تحركت
السماء وسارت وجاءت وذهبت ثم هو مع فصاحته لفظ جزل لأنه متلاقي التركيب
متقارب المخارج سهل التلفظ به مطابق المعنى وذلك هو معنى الجزالة وقد توجد
الجزالة والفصاحة في لفظ واحد وقد توجد في ألفاظ كثيرة وجمل من الكلام غير
يسيرة ولا بد من نظير تلك الكلمات.
فالنظم يطلق على مطلق التركيب
والترتيب لكنه ينقسم أقساماً فقد يقع ركيكاً وقد يقع رفيعاً ما دونها درجة
ما تتحقق في المحاورة المعتادة وفوقها ما تتحقق في المكاتبة والمراسلة
وفوقها درجة ما تذكر في الخطابة والمواعظ وفوقها درجة ما ينتظم به الشعر
وليس فوقها درجة للنظم عند العرب فهو على أقسام لا تنضبط ولذلك سمي الشعر
نظماً وما سواه نثراً قم إذا اجتمعت الفصاحة والجزالة والنظم أطلق عليها
اسم البلاغة من بلوغ الكلام درجة الكمال هذا قولنا على سبيل المباحثة
والبسط.
أما قولنا على سبيل التحديد والضبط فنقول الفصاحة عبارة عن
دلالة اللفظ على المعنى بشرط إيضاح وجه المعنى وإيضاح الغرض فيه والجزالة
عبارة عن دلالة اللفظ على المعنى بشرط قلة الحروف واختصارها وتناسب
مخارجها وربما يجتمع المعنيان فيكون اللفظ فصيحاً جزلاً معاً فتجتمع معان
كثيرة في ألفاظ يسيرة كما يقال نفل الحر ونصيب المفضل ومثاله في القرآن "
ولكم في القصاص حياة " وربما يتباينان.
والنظم ترتيب الأقوال بعضها على
بعض ثم الحسن فيه يتقدر بقدر تناسب الكلمات في أوزانها وتقاربها في
الدلالة على المعنى وذلك أنواع وأصناف.
والبلاغة عبارة عن اجتماع المعاني الثلاثة أعني الفصاحة والجزالة والنظم بشرط أن يكون المعنى مبيناً صحيحاً حسناً ومن المعلوم أن القرآن فاق كلام العرب بمحاورتها ومراسلاتها وخطبها وأشعارها فصاحة وجزالة ونظماً بحيث عجزت عن معارضتها عجز من لم يقدر عليها أولاً وآخراً لا عجز من قدر في الأول وعجز في الآخر وإلا لكانوا يعارضونه بما تمهد عندهم من الكلام الأول فالقرآن معجز من حيث البلاغة التي هي عبارة عن مجموع المعاني الثلاثة والعرب قد أحست من أنفسها أن القرآن خارج عن جنس كلامهم جملة وكذلك كل من كان له أدنى معرفة بالعربية يعرف إعجازه إلا أن البلغاء يعرفون وجوه الإعجاز فيه على قدر مراتبهم في البلاغة ومن كان أفصح وابلغ كانت معرفته أشد وأوضح كما أن من كان أسحر في زمن موسى كان علمه ومعرفته بإعجاز العصا أوفر ومن كان أحذق في الطب في زمن عيسى كانت معرفته بإعجاز إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص أكثر ومن كان أعلم في علم الطبيعة في زمن الخليل كان نفسه بإعجاز السلامة عن النار أشد وأصدق والاختلاف في وجوه الإعجاز لا يوهن وجه الإعجاز ولهذا لو اجتمع عند العالم بوجوه الإعجاز العلم بوجوه الحكم والمعاني الشريفة فيه كانت معرفته أكثر ولو ضم إلى ذلك العلم بوجوه تمهيد السياسات العامة والعبادات الخاصة والأمر بمكارم الأخلاق والنهي عن ذميمات الأفعال والحث على معالي الشيم والهمم كانت معرفته بالإعجاز في غاية الانتظام ونهاية الإبرام ومن ذا الذي يصل بفكره الضعيف وعقله الممير بمحاديات الوهم والخيال إلى الحكم المحققة في تركيب الحروف وترتيب الكلمات التي هي كالمواد والصور ومطابقتهما لعالم الخلق حتى ينطبق عالم الأمر على عالم الخلق وذلك العلم الأخص بالأنبياء عليهم السلام وهنالك تضل الأفهام وتكل الأوهام وتعود العقول البشرية عند الأسرار الإلهية هباء وتستحيل الحواس الإنسانية عند خواص الحكم الربانية عفاء " ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله " ولقد قصر من قصد إعجاز القرآن في سورة طويلة وحصره في آيات مخصوصة انظر إلى أول آية نزلت كيف اشتملت على وجوه من البلاغة والحكم " إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق " فمن أراد أن يعبر عن تقدير الخالقية عموماً لجميع الخلق في العالم ثم خصوصاً للإنسان المطابق خلقته بخلقة العالم بأسره كيف يعبر عنه بلفظ أفصح منه بياناً وأوجز لفظاً وأشرف نظماً وأبلغ عبارة ومعنى ثم انظر كيف خصص اسم الربوبية في حال تربيبه وكيف عمم الخلق أولاً ثم خصص وكيف ابتدأ خلق الإنسان من العلق حيث كانت مرتبته في حال قبول صورة الوحي مرتبة العلق من قبول صورة الإنسان إلى أن انتهى إلى البلاغ السابع من قبول جميع القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان كما ينتهي إلى المرتبة السابعة حتى يقبل علم البيان علمه البيان وكيف قرن إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم " فالحكمة في إقرأ وإقرأ أولاً وثانياً وربك الأكرم أبلغ لفظاً ومعنى من إقرأ باسم ربك ثم عمم التعلم ثم خصص الإنسان كما عمم الخلق ثم خصص الإنسان وكيف اجتمعت الفصاحة في ألفاظ بأسفار وجوه المعاني وكيف اقترنت بهذه الجزالة على قلة حروفها وخفة كلماتها من غير إخلال في الدلالة وكيف انتظمت بأشرف تركيب من حيث اللفظ وأوضح ترتيب من حيث المعنى وكيف لاحت فيها البلاغة برطوبة الألفاظ ومتانة المعاني حتى كأنها جمعت علم الأولين والآخرين من تقرير العموم والخصوص وتقدم الأمر على الخلق وإضافة الهداية والخلق إليه " تبارك الله رب العالمين " فتبين من هذه القرائن أن القرآن بجملته معجز وذلك في حق من لا يعرف دقائق البلاغة وحقائق المعاني وبعشر سور منه معجز في حق قوم وبسورة واحدة معجز في حق قوم وبآية واحدة معجز في حق قوم وتتقدر مقادير الإعجاز على قدر الدراية والتحقيق.
ومن العجب أن المعتزلة قالوا بوجوب النظر
قبل ورود الشرع وبنوا ذلك على أن العاقل المفكر لا يخلو عن خاطرين يطرآن
على قلبه أحدهما يدعوه إلى النظر حتى يعرف الصانع فيشكر فيثاب على شكره
والثاني يمنعه عن ذلك فيختار بعقله أحق الطريقين بالأمن ويرفض أحقهما
بالخوف فيقال لهم إذا تحدى النبي بالرسالة وأخبر أنه رسول الله كان خبره
محتملاً للصدق والكذب فهلا طرأ الخاطران في تصديقه وتكذيبه ثم يحصل الخبر
بالصدق أولى فإن فيه الأمن إذ لو كان صادقاً فكذبه خسر ولو كان كاذباً
فصدقه لم يخسر فإنه إن يكن كاذباً فعليه كذبه وفي طلب المعجزة منه خطر آخر
وهو جعل الخبر أولى بالكذب فكأنه يكذبه في الحال إلى أن تظهر المعجزة
فيصدقه في ثاني الحال وعند المعتزلة القرآن من جنس كلام العرب فإنهم
يقدرون على مثله قدرتهم على كلامهم فلم يستمر لهم التمسك بإعجاز القرآن.
قال
أهل الزيغ إذا قال النبي إني رسول الله إليكم وأنه أنزل علي كتاباً أقرأه
عليكم فما المعني بالرسالة عن الله تعالى وما معنى قوله إني نبي الله
أفترجع الرسالة والنبوة إلى صفة قائمة بذاته بها يستحق أن يخاطب الناس
بالأوامر والنواهي عن الله تعالى أم ترجع إلى إخبار الله تعالى أنه رسولي
فإن كان الأول فما حقيقة تلك الصفة وإن كان الثاني فكيف يتصور أن يكلم
الله بشراً فإن الذي يسمعه البشر من الكلام حروف وأصوات وعندكم كلامه ليس
بحرف ولا صوت وإن كان وحياً من الله تعالى فما معنى الوحي وكيف يتصور أن
ينزل ملك على صورة البشر فإن كان الملك شخصاً جسمانياً فيجب أن يكون على
صورة بشر حتى يكلمه بكلام البشر وإن كان جوهراً روحانياً فكيف يتصور أن
يتشخص ويظهر بشخص جسماني أليس نفس الدعوى إذا لم تكن معقولة في نفسها لم
يجز مطالبته بالبرهان عليها فلا نزول الملك معقول ولا نزول القرآن الذي هو
كلامه معقول بل عما مستحيلان عند العقلاء بأسرهم وأيضاً فإنه ادعى بعد ذلك
صعوده إلى السماء والجسماني الكثيف يستحيل أن يصعد والأجرام العلوية لا
تقبل الخرق وإذا اشتمل كلامه على ما يستحيل في العقل حكم ببطلان أصل دعواه
إلى غير ذلك مما ادعى أنه شاهد العوالم وأخبر عن حشر الأجسام والأحياء في
القبور والميزان والصراط والحوض بعد ذلك فإن هذه غير معقولة بل قبولها على
الوجه الذي يدعيه مستحيل.
قال أهل الحق النبوة ليست صفة راجعة إلى
نفس النبي ولا درجة يبلغ إليها أحد بعلمه وكسبه ولا استعداد نفسه يستحق به
اتصالاً بالروحانيات بل رحمة من الله تعالى ونعمة يمن بها على من يشاء من
عباده وكما قال نوح عليه السلام " ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم
الغيب ولا أقول إني ملك " إلى غيره من الأنبياء وسيد البشر صلى الله عليه
وسلم قال كما قال الأول " قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً قل لا
أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت
من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون " لعمري لا
تعدم نفس النبي ومزاجه كمالية في الفطرة وحسناً في الأخلاق وصدقاً وأمانة
في الأقوال والأفعال قبل بعثه لأنه بها استحق النبوة أو وصل بسببها إلى
الاتصال بالملائكة وقبول الوحي كما قال تعالى " فبما رحمة من الله لنت لهم
ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك " وكما قال القوم " لولا نزل هذا
القرآن على رجل من القريتين عظيم " قال سبحانه " أهم يقسمون رحمة ربك "
فشخص النبي صلى الله عليه وسلم شخص الرحمة ورحمة مشخصة ورسالته إلى الخلق
رحمة ونعمة كما قال تعالى " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعرفون نعمة
الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون " والأنبياء خيرة الله في خلقه وحجة
الله على عباده والوسائل إليه وأبواب رحمته وأسباب نعمته " الله يصطفي من
الملائكة رسلاً ومن الناس " " إن الله اصطفى آدم ونوحاً " الآية فكما
يصطفيهم من الخلق قولاً بالرسالة والنبوة يصطفيهم من الخلق فعلاً بكمال
الفطرة ونقاء الجوهر وصفاء العنصر وطيب الأخلاق وكرم الأعراق فيرقيهم
مرتبة مرتبة حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة وكملت قوته النفسانية
وتهيأت لقبول الأسرار الإلهية بعث إليهم ملكاً وأنزل عليهم كتاباً ولا تظن
أن الملك يتجسد شخصاً بمعنى أنه يتكاثف بعد ما كان جسماً لطيفاً تكاثف
الهواء اللطيف غيماً كما ظنه قوم ولا أنه تعدم حقيقته ويوجد شخص آخر ولا
أنه تنقلب حقيقته إلى حقيقة أخرى فإن كل ذلك محال بل الجواهر النورانية
خصت بقوة الظهور بأي شخص أرادوا كما قال تعالى " فأرسلنا إليها روحنا
فتمثل لها بشراً سوياً " وكما قال " ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً " ولا
نجد له مثالاً في هذا العالم إلا تمثل تعلق أرواحنا بأجسادنا غير أن
التمثل يستدعي شخصاً كاملاً في الحال والتعلق يستدعي شخصاً يتكون مرتبة
فمرتبة سلالة ونطفة وعلقة ومما نذكره مثالاً تمثل المعنى الذي في الذهن
بالعبارات التي في اللسان وبالكتابة التي في اللوح غير أن اللفظ دليل على
المعنى وكل دليل مظهر المعنى من وجه وكل مظهر دال على المعنى من وجه من
غير حلول الأعراض في الجواهر ولا نزول الأجسام على الأجسام وإن تخطيت منه
إلى ظهور صورة الشخص في المرآة الصقيلة ووقوع الظل على الماء الصافي قارنت
المعنى مثالاً وإدراكاً.
ألستم تقولون معاشر الصابئة المحيلين نزول
الروحاني على الجسماني أن كل روحاني له هيكل يظهر به ويتصرف فيه ويستوي
عليه وكل هيكل في العالم العلوي له شخص في العالم السفلي يظهر به ويتصرف
فيه ويستوي عليه غير أنكم اتخذتم بصنعتكم أصناماً آلهة وهي مظاهر تلك
الهياكل التي هي مظاهر تلك الروحانيات.
ونحن معاشر الحنفاء أثبتنا
أشخاصاً ربانية مفطورة بوضع الخلقة على اصطفاء من الجواهر واجتباء من
العنصر مناسبة لتلك الجواهر الروحانية مناسبة النور للنور والظل للظل
وللنبي عليه السلام طرفان بشرية ورسالية " قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً
رسولاً " فبطرف يقبل الوحي وبطرف يؤدي الرسالة والوحي هو إلقاء الشيء إلى
الشيء بسرعة فكل صورة علمية يقبلها بطرفه الروحانية عن الملائكة الذين هم
رسل ربهم إليه دفعة واحدة كوقوع الصورة في المرآة فهو وحي وأقرب مثال له
إلينا المنام الصادق فإن الرائي يرى كأنه نزل بستاناً واجتنى ثماراً وخاض
في الماء وتحدث أحاديث كثيرة من سؤال وجواب وأمر ونهي بحيث لو أملاها ملأت
أوراقاً وشحنت صفائح صحائف وكل ذلك في غفوة كأنها لحظة وما ذاك إلا لأن
الصور والفعلية القولية إذا كانت من عالم المعاني بواسطة تلك المنام لم
يستدع زماناً ولا ترتيباً بحيث يستدعيها حال اليقظة بل وقعت دفعة واحدة في
نفس الرائي حتى انتقشت فيه ثم عبر عنه بعبارات كثيرة وعبر المعبر عن صورها
الخيالية إلى معانيها العقلية ولذلك صارت الرؤيا الصادقة جزءاً من أجزاء
النبوة كما صارت التؤدة والأناة وحسن السمت جزءاً من أجزاء النبوة فالنبوة
إذاً جملة ذات أجزاء وتلك الجملة بمجموعها لا تتحقق إلا لمن اصطفاه الله
تعالى لرسالته وبعض أجزائها قد ثبت للصالحين من عباده فيبلغون إلى ذلك
الجزء بطاعتهم وعبادتهم كما قال صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أصدقكم
حديثاً إما مجموعها من حيث المجموع فلا يصل إليه أحد بكسبه واستطاعته.
وأما
نزول كلام الباري تعالى فمعنى نزول الملك به فليس يستدعي النزول انتقالاً
فإنك تقول نزلت عن كلامي ونزل الأمير عن حقه وقد ورد إلي الخبر نزول الرب
تعالى إلى السماء الدنيا وورد في القرآن مجيئه وإتيانه وذلك لا يستدعي
انتقالاً كما حقق في التأويلات ثم الكلام الذي هو أمره الأزلي لا يطلق
عليه النزول إلا بمعنى نزول الآيات الدالة عليه ثم الإلزام على الخصم إنما
يظهر إذا أثبتنا له أمراً ونهياً وإثبات الأمر إنما يظهر إذا توافقنا على
أنه تعالى ملكاً ومالكاً وله أن يتصرف في ملكه بالأمر والنهي والتكليف على
من ثبت له اختيار وإذا حصل وفاقنا على هذه المراتب وعلمنا أن كل واحد من
آحاد الناس لا يتأهل لقبول أمر الله تعالى وحباً له تعين بالضرورة واحداً
اصطفاه من عباده " وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة " فدعواه
نفسها ما الجائزات العقلية وإذا كانت الدعوى مقرونة بدليل الصدق وجب
التصديق ووجب أن لا يتراخى دليل الصدق عن نفس الخبر فإن المخاطب مكلف
بالتصديق في الحال ولا يتراخى الوجوب عليه إلا أن يعرف الصدق بل التمكن
كاف كما بينا ولكن التمكن إنما تحقق من جانب المكلف بوجود العقل التام
والعقل إنما يدرك إذا وجد دليل الصدق فكما لا يتراخى الوجوب عن وقت
التكليف لا يتراخى أيضاً دليل الصدق عن نفس الدعوى فليبحث ها هنا كل البحث
أن الدليل المقرون بالخبر والدعوى ماذا بحيث لا يلزم إفحام ولا ينفع إحجام
وأما سائر الأخبار السمعية فإذا ثبت صدق النبي وجب الإيمان بذلك والسمع
والطاعة له فإن عرفنا له وجهاً بالدليل العقلي فبصيرة وخيرة وإن لم تعرف
له وجهاً فتسليم وتصديق وما يستحيل في العقل وكان بين الاستحالة يعرف وجه
استحالته ونعلم أن الصادق الأمين لا يقرر المستحيل فيطلب لكلامه محملاً
صحيحاً فإذا وجدناه فخيرة وإلا أمنا وصدقنا بالظاهر ووكلنا علم الباطن إلى
الله تعالى ورسوله.
فمن ذلك حشر الأجسام وبعث من في القبور من
الأشخاص فاعلم أنه لم يرد في شريعة ما من الدلائل أكثر مما ورد في شرعنا
من حشر الأجسام وكأن الزمان لما كان مقروناً بالقيامة كانت الآية أصرح بها
والبينات أدل عليها ومفارقة الأرواح للأجساد وبقاء الأرواح قد اعترف بها
الحكماء الإلهيون وحشر الأجساد لما كان ممكناً في ذاته وقد ورد به الصادق
وجب التصديق بذلك من غير أن يبحث عن كيفية ذلك إذ الرب تعالى قادر على
الإعادة وقدرته على الإنشاء والابتداء فيحيي العظام وهي رميم كما أنشأها
أول مرة وكما يحيي الأرض بعد موتها كل ربيع كذلك يحيي الموتى ودليل من رام
إثباته على طريق الحكمة هو أن النفوس الجزئية إذا فارقت الأبدان ولم تستقر
في تصوراتها عن آلات جسمانية احتاجت إلى الأبدان ضرورة وإلا كانت معذبة
فإن سعادتها في تصوراتها إنما تكون بآلاتها والآلات إنما تتحقق إذا عادت
بسعيها كما كانت فمن قال بحشر الأجسام وفى بقضية الحكمة إذ وفر على كل نفس
حظها من كمالها اللائق بها وإعطاءها جزاءها على مقدار سعيها ومن نفى ذلك
قضى بالحشر على نفس أو نفسين في كل عصر قد تجردت عن المواد الجسمانية وقضى
بالتعذيب على كل نفس في العالم وذلك يناقض الحكمة وأيضاً فإن الترتيب بين
كل نفس ونفس حاصل في الدنيا وإذا فارقت النفس البدن فإما أن يزول الترتيب
حتى يستوي الحال بين من حصل لنفسه علوماً كثيرة وبين من اشتمل على جهالات
كثيرة وإما أن يثبت الترتيب وليس في ذلك العالم جنة ولا نار عندهم فيحصل
لهم بذلك لذة أو ألم إذ لا نعمة ثم معدة لأهل السعادة ولا عذاب مدخر لأهل
الشقاوة وإنما اللذة والألم والنعمة والعذاب تنشأ من كل نفس أو لازم كل
نفس بحسب ما استعدت له من العلم والجهل إلى تناقضات كثيرة أوردنا لذكرها
رسالة في المعاد.
وأما سؤال القبر وعذابه فقد ورد بهما الخبر الصحيح في
كم موضع حتى بلغ الاستفاضة وهو حق وأما وجه ذلك على الطريقة المرضية ليس
ذلك للروح المجرد خاصة ولا للبدن على هذه الهيئة المشاهدة حتى يلزم عليه
ما يناقض الحس ولو كان الخطاب أعني خطاب الملكين خطاباً بالاعتقاد المجرد
لكان التزام الاعتقاد على الروح المجرد ولو كان الخطاب بالاعتقاد دون
القول والعمل جميعاً لكان يشترط فيه حشر الجسد على الصورة المخصوصة لكنه
خطاب يقتضي عقداً وجواباً من حيث القول من ربك وما دينك ومن نبيك فلو كان
الرجل حياً وتوجه عليه هذا الخطاب استدعي منه فهماً للخطاب وجواباً
والأجزاء الفاهمة من الإنسان والناطقة أجزاء مخصوصة وتلك الأجزاء مستقلة
بالجواب وإن كان الشخص من حيث هو شخص غير مستشعر بذلك كالنائم مثلاً أو
كالسكران فيجوز أن يحيي الله تعالى تلك الأجزاء ويكون السؤال متوجهاً
عليها من حيث أنها فاهمة وناطقة ثم يكون الحشر بعده للشخص بصورته إذ
السؤال متوجه عليه حتى يخرج عن عهدة العقد والقول والعمل.
وأما الميزان
فقد ورد الكتاب العزيز به في قوله تعالى " ونضع الموازين القسط ليوم
القيامة " وقد قيل أن الموزون به جسم أما كاغد مكتوب عليه خيرات العباد
وشروره ثم يخلق الله فيه ثقلاً أو خفة فيترجح به الميزان والأحرى أن يقال
أن لكل شيء في العالم ميزان لائق بوجود ذلك الشيء فميزان ما يقبل الثقل
والخفة المعيار والميزان المعهود وميزان المكيلات الكيل والمذروعات الذرع
والمسافات الفراسخ والأميال والمعدودات العدد وميزان الأعمال والأقوال ما
يكون لائقاً بها والله أعلم بما أراد.
وأما الحوض والشفاعة فالحوض يجري على ظاهره وهو كالأنهار التي تكون في
الجنة من شرب منه شربة في القيامة لم يظمأ بعدها أبداً.
وأما
الشفاعة فقد قالت المعتزلة أنها للمطيعين من المؤمنين بناء على مذهبهم أن
الفاسق إذا خرج من الدنيا من غير توبة خلد في النار لأنه قد استوجب النار
بفسقه ومن دخل النار كان مغضوباً عليه ومن كان مغضوباً عليه لا يدخل الجنة
وأيضاً فإنه في حال الفسق ما استحق اسم الإيمان لأن الإيمان عبارة عن خصال
محمودة يستوجب المؤمن بها المدح والثناء والفاسق لا يستوجب المدح وقد أخلى
أركان إيمانه بخروجه عن الطاعة واستدلوا على ذلك بآيات من الكتاب منها
قوله تعالى " ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها "
وقوله تعالى " بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم
فيها خالدون " وقوله تعالى " ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً
فيها " وأيضاً فإن الرب تعالى ذكر حال الأشقياء وحال السعداء وربط الخلود
بمكانهما ولم يذكر في القرآن قسماً ثالثاً فقال " فأما الذين شقوا وأما
الذين سعدوا " وفي تفصيل الفريقين فريق في الجنة وفريق في السعير.
وزادت
الخوارج عليهم بأن كفروا صاحب الكبيرة واستدلوا عليه بقصة إبليس إذ كان
عارفاً بالله مطيعاً له غير أنه ارتكب كبيرة وهو الامتناع من السجود لآدم
عليه السلام فاستوجب اللعن والتكفير والتخليد في النار.
وقصرت المرجئة في مقابلتهم حيث قالوا الإيمان قول وعقد وإن عري عن العمل
فلا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
وأشدهم
تقصيراً الكرامية الذين ينفر الطبع السليم عن نقل مقالاتهم وذكر مذاهبهم
لخبثها وركاكتها قالت الإيمان قول مجرد وهو الإقرار باللسان فحسب وإن كان
المقر كاذباً منافقاً فهو مؤمن وليتهم قالوا مؤمن عندنا بل قالوا مؤمن
حقاً عند الله تعالى حتى يثبت في حقه مشاركته المؤمنين في أحكام الإسلام.
قالت الأشعرية الإيمان عبارة عن التصديق في وضع اللغة وقد قرره الشرع على
معناه.
واختلف
جواب أبي الحسن رحمه الله في معنى التصديق فقال مرة هو المعرفة بوجود
الصانع وإلاهيته وقدمه وصفاته وقال مرة التصديق قول في النفس يتضمن
المعرفة ثم يعبر عن ذلك باللسان فيسمي الإقرار باللسان أيضاً تصديقاً
والعمل على الأركان أيضاً من باب التصديق بحكم الدلالة أعني دلالة الحال
كما إن الإقرار تصديق بحكم الدلالة أعني دلالة المقال فكان المعنى القائم
بالقلب هو الأصل المدلول والإقرار والعمل دليلان.
قال بعض أصحابه
الإيمان هو العلم بأن الله ورسوله صادقان فيما أخبرا به ويعزى هذا أيضاً
إلى أبي الحسن ثم القدر الذي يصير به المؤمن مؤمناً وهو التكليف العام على
عوام الخلق وخواصهم هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في
ملكه ولا نظير له في جميع صفات إلاهيته ولا قسيم له في أفعاله وأن محمداً
رسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فإذا أتى بذلك لم ينكر
شيئاً مما جاء به وأنزل به فهو مؤمن فإن وافاه الموت على ذلك كان مؤمناً
عند الله وعند الخلق وإن طرئ عليه ما يضاد إيمانه ذلك والعياذ بالله حكم
عليه بالكفر عند ذلك وإن اعتقد مذهباً يلزمه من حكم مذهبه مضادة ركن من
هذه الأركان لم يحكم بكفره مطلقاً بل ينسب إلى الضلالة والبدعة ويكون حكمه
في الآخرة موكولاً إلى الله تعالى تخليداً في النار أو تأقيتاً.
والدليل
على ما ذكرناه أنا بالتواتر المفضي إلى اليقين علمنا أن النبي عليه السلام
لما أظهر الدعوة دعا الناس إلى كلمتي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول
الله ونعلم قطعاً أنه لم يرض منهم في هذه الشهادة بمجرد القول مع إضمار
خلافه في القلب إذ قرر لهذا المعنى قوماً سماهم منافقين وسماهم الكتاب
بذلك مع نفي الإيمان عنهم كما قال تعالى " ومن الناس من يقول آمنا بالله
واليوم الآخر وما هم بمؤمنين " ونسبهم إلى الكذب وسماهم كاذبين في غير آي
من الكتاب والله يشهد أن المنافقين لكاذبون والكرامي يشهد أن المنافقين
لصادقون فقد علم من ذلك قطعاً أن التصديق بالقلب ركن وهو الركن الأعظم إذ
الإقرار باللسان يعبر عنه ونعلم قطعاً أن النبي عليه السلام كما لم يرض
منهم بمجرد القول ما لم يقترن به عقد لم يكلف جميع الخلق معرفة الله تعالى
كما هو لأن ذلك غير مقدور للخلق وأقرب دليل على ذلك أنه تعالى يعلم جميع
معلوماته على التفصيل ويعلم أنه يخلق جميع مخلوقاته على التفصيل ويعلم
جميع مراداته من الخلق وللخلق وليس يعلم العبد ذلك ولا يقدر أن يعلم ولم
يكلف إلا أن يعرف أنه لا إله إلا الله وتكون معرفته مستندة إلى دليل جلي
كما ورد به التنزيل وإلا فتكليف ذلك شطط لا يستطاع فثبت القول والعقد
مصدراً ومظهراً وقد يكتفى بالمصدر في القلب إذا لم يقتدر على الإتيان
بالإقرار باللسان لكن في حكم الله تعالى الإشارة في حق الآخرين تنزل منزلة
العبارة في حق الناطق وقصة الخرساء أعتقها فإنها مؤمنة دليل على صحة ما
ذكرناه في أصل الإيمان وقدره بقي كون العمل ركناً أو واجباً تابعاً.
فتقول المرجئة بإرجاء العمل كله عن القول والعقد حتى قالت لم يضر العبد إن
لم يأت بطاعة واحدة.
وتقول
الوعيدية بكونه ركناً من الأركان أن العبد تخلده الكبيرة في النار مع
الكفار حتى قالت يسلب اسم الإيمان عمن ترك طاعة واحدة وكلا المذهبين مردود.
أما
الأول فيرفع معظم التكاليف من الأوامر والنواهي ويفتح باب الإباحة ويفضي
إلى الهرج وإذ ورد في الشرع بذلك كله وربط بكل حركة من حركات الإنسان
حكماً بحكم أنه إن لم تضره المعاصي لم تنفعه الطاعات وأنه إن لم يكن
مؤاخذاً بترك ما أمر به لم يكن مثاباً بامتثال ما أمر.
وأما المذهب
الثاني فيرفع معظم الآيات من الكتاب والأخبار والسنة وتغلق باب الرحمة
ويفضي إلى اليأس والقنوط وإذ ورد في الكتاب في كم آية " إن الذين آمنوا
وعملوا الصالحات " ففرق بين لفظ الإيمان والعمل واعلم أن الإيمان له حقيقة
والعمل له حقيقة غير الإيمان وخاطب في كم آية الفاسقين بخطاب المؤمنين يا
أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا علم بذلك قطعاً أن الإيمان لو كان هو
العمل بعينه أو كان العمل ركناً مقيماً بحقيقة الإيمان لما ميز بهذا
التمييز وأيضاً فيلزم الوعيدية أن لا يوجد مؤمن في العالم إلا نبي معصوم
إذ لا عصمة لغير الأنبياء ويلزم أن لا يطلق اسم الإيمان على أحد حتى
يستوفي جميع خصال الخير عملاً وفعلاً فيكون اسم الإيمان موقوفاً على العمل
في المستأنف فهؤلاء مرجئة الإيمان عن العمل وأولئك مرجئة العمل عن الإيمان
فعلم قطعاً أن العمل غير داخل في الإيمان ركناً مقوماً له حتى يقال بعدمه
يكفر ويخرج عن الإيمان في الحال ويعذب ويخلد في النار في ثاني الحال وغير
خارج عن الإيمان تكليفاً لازماً له حتى يقال بعدمه لا يستحق لوماً وزجراً
في الحال ولا استوجب عقاباً وجزاءً في المآل والقول بأن المعاصي تحبط
الطاعات ليس بأولى من القول بأن الطاعات ترفع المعاصي ومن قال صاحب
الكبيرة يخلد في النار بشرط تخفيف العذاب عليه بسبب تصديقه قولاً وعقداً
وطاعته المحبطة يعارضه قول المرجئ تخليد في الجنة بشرط حطه عن درجة
المطيعين بسبب إيمانه وسائر طاعاته والطاعات لو أحبطت كيف أثرت في التخفيف
والتخفيف كيف يتصور مع التخليد والتخليد كيف يجوز في العدل على عمل مقدر
بوقت بل وتخليد الكافر في النار متى كان عدلاً عقلياً وهو لم يكفر إلا
مائة سنة فهلا تقدر التعذيب بمائة سنة أفمن غصب مائة دينار وأخذ منه مائتي
دينار كان عدلاً قال هو على اعتقاد أنه لو بقي أبد الدهر بقي على الكفر
قيل واعتقاد أنه يعمل غير اعتقاد أن عمل أليس من غصب مائة دينار على
اعتقاد أن لو ظفر لم يؤاخذ بالألف كذلك فيما نحن فيه فالعدل المعقول إذاً
ما ورد الشرع به والحكم المشروع ما دل العقل عليه وهو أن العبد إذا كان
مصدقاً بقلبه مخبراً عن تصديقه بلسانه مطيعاً لله تعالى في بعض ما أمره به
عاصياً له في البعض استحق المدح بقدر ما أطاع واللوم بقدر ما قد عصى في
الحال واستحق الثواب بقدر الإيمان والطاعة والعقاب بقدر العصيان في المآل
ثم يبقى أن يتعارض أمران أحدهما أن يثاب أو لا ثم يعاقب مخلداً أو بالعكس
وليس في الفضل والعدل القسم الأول فإن رحمة الله أوسع من ذنوب الخلق وفضله
أرجى من العمل ولا تنقصه المغفرة ولا تضره الذنوب ولأن الإيمان والمعرفة
أحق بالتخليد عدلاً وعقلاً من معصية مؤقتة ولأنه لم يؤثر أن أحداً يخرج من
الجنة إلى النار فيقي القسم الثاني وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قد
وردت سمعاً حيث قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
وما تمسكوا به من
الآيات فمخصوصات عموماتها محمولة على الاستحلال وظواهرها معارضة بآيات دلت
على ذلك منها قوله تعالى " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء " ومنها قوله تعالى " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً " وإن خص هذا العام
بالتوبة من غير دلالة التخصيص فخص تلك العمومات بحال الاستحلال في كل آية
دليل على التخصيص وأما قوله تعالى " ومن يعص الله ورسوله " فمعناه يكفر به
ورسوله لأنه قرنه بقوله " ويتعد حدوده " وتعدي جميع الحدود لا يتصور إلا
من الكافر وأما المؤمن المطيع لله عز وجل سبعين سنة كيف يكون متعدياً جميع
الحدود بمعصية واحدة وكذلك قوله " بلى من كسب سيئة " أي شركاً بدليل قوله
وأحاطت به خطيئته والإحاطة من كل وجه لا يتصور في حق المؤمن لأنه بإيمانه
منع الإحاطة من كل وجه وقوله تعالى " ومن يقتل مؤمناً متعمداً " فمعناه
مستحلاً قتله لأن العمدية المطلقة من كل وجه لا تتصور إلا من الكافر
ودليله آخر الآية من التشديد في العقاب والتغليظ بالغضب واللعن وذلك
بالاتفاق غير مطلق على القاتل الذي لا يستحل الدم وهو خائف وجل وذكر حال
الأشقياء والسعداء مقصور على مآل الحال " فأولئك مآلهم إلى النار خالدين
فيها وهؤلاء مآلهم إلى الجنة خالدين فيها " والدليل عليه الاستثناء في آخر
الآية.
القول في الإمامة اعلم أن الإمامة ليست من أصول الاعتقاد
بحيث يفضي النظر فيها إلى قطع ويقين بالتعين ولكن الخطر على من يخطي فيها
يزيد على الخطر على من يجهل أصلها والتعسف الصادر عن الأهواء المضلة مانع
من الإنصاف فيها.
وقد قال جمهور أصحاب الحديث من الأشعرية والفقهاء
وجماعة الشيعة والمعتزلة وأكثر الخوارج بوجوبها فرضاً من الله تعالى ثم
جماعة أهل السنة قالوا هو فرض واجب على المسلمين إقامته واتباع المنصور
فرض واجب عليهم إذ لا بد لكافتهم من إمام ينفذ أحكامهم ويقيم حدودهم ويحفظ
بيضتهم ويحرس حوزتهم ويعبي جيوشهم ويقسم غنائمهم وصدقاتهم ويتحاكموا إليه
في خصوماتهم ومناكحاتهم ويراعي فيه أمور الجمع والأعياد وينصف المظلوم
وينتصف من الظالم وينصب القضاة والولاة في كل ناحية ويبعث القراءة والدعاة
إلى كل طرف وأما العلم والمعرفة والهداية فهي حاصلة للعقلاء بنظرهم الثاقب
وفكرهم الصائب ومن زاغ عن الحق وضل عن سواء السبيل فعلى الإمام تنبيهه على
وجه الخطأ وإرشاده إلى الهدى فإن عاد وإلا فينصب القتال ويطهر الأرض عن
البدعة والضلال بالسيف الذي هو بارق سطوة الله تعالى وشهاب نقمته وعقبة
عقابه وعذبة عذابه.
والدليل الساطع على وجوب الإمامة سمعاً اتفاق الأمة بأسرهم من الصدر الأول
إلى زماننا أن الأرض لا يجوز أن تخلو عن إمام قائم بالأمر.
أما
الصدر الأول فقد قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته قبل البيعة أيها الناس
من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت
وتلا هذه الآية " وما محمد إلا رسول قد خلت " ثم قال وإن محمداً قد مضى
بسبيله ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم
الله فناداه الناس من كل جانب صدقت يا أبا بكر ولكنا نصبح وننظر في هذا
الأمر ونختار من يقوم به ولم يقل أحد أن هذا الأمر يصلح من غير قائم به ثم
كان من أمر الأنصار من اختيار سعد بن عبادة وقولهم منا أمير ومنكم أمير
قام أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مع جماعة من المهاجرين يقصدون سقيفة بني
ساعدة وقال عمر كنت أزور في نفسي كلاماً في الطريق حتى وافينا السقيفة
هممت أن أتكلم به فقام أبو بكر وقال مه يا عمر وذكر جميع ما كنت أزوره إلا
أنه كان ألين وكنت أخشن فبايعته وبايعه الناس القصة المشهورة ولما قرب
وفاة أبي بكر رضي الله عنه فقال تشاوروا في هذا الأمر ثم وصف عمر بصفاته
وعهد إليه واستقر الأمر عليه وما دار في قلبه ولا في قلب أحد أن يجوز خلو
الأرض عن إمام ولما قربت وفاة عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين ستة
وكان الاتفاق على عثمان رضي الله عنه وبعد ذلك كان الاتفاق على علي رضي
الله عنه فدل ذلك كله على أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم الصدر الأول
كانوا على بكرة أبيهم متفقين على أنه لا بد من إمام ويدل على ذلك إجماعهم
على التوقف في الأحكام عند موت الإمام إلى أن يقوم إمام آخر ومن ذلك
الزمان إلى زماننا كانت الإمامة على المنهاج الأول عصراً بعد عصر من إمام
إلى إمام إما بإجماع من الأمة أو بعهد ووصية وإما بهما جميعاً فذلك
الإجماع على هذا الوجه دليل قاطع على وجوب الإمامة العالم كلامنا في وجوب
الإمامة على الإطلاق.
أما القول في تعيين الإمام هل هو ثابت بالنص أم
بالإجماع فالقائلون اختلفوا في أن النص ورد على شخص بعينه أم ورد بذكر
صفته فالقائلون بالإجماع اختلفوا في أن إجماع الأمة عن بكرة أبيهم شرط في
ثبوت الإمامة أم يكتفى بجماعة من أهل الحل والعقد وقد ذكرت مذاهبهم في
الكتب.
قال أهل السنة القائلون بالإجماع الدليل على عدم النص على إمام
بعينه هو أنه لو ورد نص على إمام بعينه لكانت الأمة بأسرهم مكلفين بطاعته
ولا سبيل لهم إلى العلم بعينه بأدلة العقول والخبر لو كان تواتراً لكان كل
مكلف يجد من نفسه العلم بوجوب الطاعة له وإلا لزمه ديناً كما لزمه الصلوات
الخمس ديناً ولما جازوا إلى غيره بيعة وإجماع.
ومن المحال من حيث
العادة أن يسمع الجم الغفير كلاماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا
ينقلونه في مظنة الحاجة وعصيان الأمة بمخالفته والدواعي بالضرورة تتوفر
على النقل خصوصاً وهم في نأنأة الإسلام وطراوة الدين وصفوة القلوب وخلوص
العقائد عن الضغائن والأحقاد والتآلف المذكور في الكتاب العزيز " وألف بين
قلوبهم فأصبحتم بنعمته إخواناً " وإذا كانت الدواعي على النقل موجودة
والصوارف عنه مفقودة ولم ينقل دل على أنه لم يكن في الباب نص أصلاً وأيضاً
لو عين شخصاً لكان يجب على ذلك الشخص المعين أن يتحدى بالإمامة ويخاصم
عليها ويخوض فيها حتى إذا دفع عن حقه سكت ولزم بيته فيظهر الظالم عليه ولم
ينقل أن أحداً تصدى للإمامة وادعاها نصاً عليه وتسليماً إليه.
قالت
النجدات من الخوارج وجماعة من القدرية مثل أبي بكر الأصم وهشام الفوطي أن
الإمامة غير واجبة في الشرع وجوباً لو امتنعت الأمة عن ذلك استحقوا اللوم
والعقاب بل هي مبنية على معاملات الناس فإن تعادلوا وتعاونوا على البر
والتقوى واشتغل كل واحد من المكلفين بواجبه وتكليفه استغنوا عن الإمام
ومتابعته فإن كل واحد من المجتهدين مثل صاحبه في الدين والإسلام والعلم
والاجتهاد والناس كأسنان المشط والناس كابل ماية لا تجد فيها راحلة فمن
أين يلزم وجوب الطاعة لمن هو مثله.
وزادوا على ذلك تقريراً بأن قالوا
وجوب الطاعة لواحد من الأمة إما أن يثبت بنص من الرسول فقد دللتم على أنه
لا نص على أحد وإما أن يكون باختيار من المجتهدين والاختيار من كل واحد من
الأمة إجماعاً بحيث لا يقدر فيه اختلاف لا يتصور عقلاً ولا وقوعاً أما
العقل فإن الاختيار إذا كان مبنياً على الاجتهاد والاجتهاد ينبني على ما
تعين لكل واحد من العقلاء من قضايا تردده في الوجوه العقلية والسمعية وذلك
إذا كان مختلفاً في الطباع فبالضرورة أن يصير مختلفاً في الحكم أليس أحق
الأحكام بوجود الاتفاق فيه الخلافة الأولى وأولى الأزمان في الشرع هو
الزمان الأول وأولى الأشخاص بالصدق والإخلاص الصحابة وأحق الصحابة
بالأمانة ونفي التهمة والخيانة المهاجرون والأنصار وأقرب الناس إلى رسول
الله أبو بكر وعمر فانظر كيف انحاز الأنصار إلى السقيفة وكيف قالوا منا
أمير ومنكم أمير وكيف أجمعوا على سعد بن عبادة لولا أن تداركه عمر بأن
بايع بنفسه حتى شايعه الناس ثم قال بعد ذلك ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة
فوقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فأيما رجل بايع رجلاً من غير مشورة من
المسلمين فإنها تغره أن يقتلا يعني أني بايعت أبا بكر وما شاروت الجماعة
ووقى الله شرها فلا تعودوا إلى مثلها ولم يكن وقت البيعة اتفاق الجماعة
وفي الغد لما بايعوه انحازت بنو أمية وبنو هاشم حتى قال أبو سفيان لعلي
رضي الله عنه لم تدع هذا الأمر حتى يكون في شر قبيلة من قريش فأجابه علي
فتنتنا وأنت كافر وتريد أن تفتننا وأنت مسلم وقال العباس قولاً مثل ذلك
وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبي وأبو بقية الأمة الخلافة في
ولدك وما اختلف الليل والنهار ولم يخرج علي رضي الله عنه إلى البيعة حتى
قيل أنه كان له بيعة في السر وبيعة في العلانية وقد خرج أسامة بن زيد وهو
على جيشه أمير بتأمير النبي صلى الله عليه وسلم.
قالوا فإذا لم يتصور إجماع الأمة في أهم الأمور وأولاها بالاعتبار دل على
أن الإجماع لن يتحقق قط وليس ذلك دليلاً في الشرع.
قالوا
ونصب الإمامة بالاختيار متناقض من وجهين أحدهما أن صاحب الاختيار موجب في
النصب على الإمام حتى يصير إماماً ويجب عليه طاعته إذا قام بالإمامة فهو
إنما صار إماماً بإقامته فكيف صار واجب الطاعة بإمامته والثاني أن كل واحد
من المجتهدين الناصبين للإمامة لو خالف الإمام في المسائل الاجتهادية
باجتهاده جاز له ذلك وما من مسئلة فرضتم وجوب الطاعة له فيها إلا ويجوز
المخالفة له فيها باجتهاده فكيف نجعله إماماً واجب الطاعة بشرط أن يخالفه
إذا أدى إلى المخالفة اجتهاده.
قالوا فدل هذا كله على أن الإمامة
غير واجبة في الشرع نعم لو احتاجوا إلى رئيس يحمي بيضة الإسلام ويجمع شمل
الأنام وأدى اجتهادهم إلى نصبه مقدماً عليهم جاز ذلك بشرط أن يبقى في
معاملاته على النصفة والعدل حتى إذا جار في قضية على واحد وجب عليهم خلعه
ومنابذته وهذا كما فعلوا بعثمان وعلي رضي الله عنهما فإنه لما أحدث عثمان
تلك الأحداث خلعوه فلما لم ينخلع قتلوه ولما رضي علي بالتحكيم وشك في
إمامته خلعوه وقاتلوه.
قالت الشيعة الإمامة واجبة في الدين عقلاً وشرعاً كما أن النبوة واجبة في
الفطرة عقلاً وسمعاً.
أما
وجوب الإمامة عقلاً أن احتياج الناس إلى إمام واجب الطاعة يحفظ أحكام
الشرع عليهم ويحملهم على مراعاة حدود الدين كاحتياج الناس إلى نبي مرسل
يشرع لهم الأحكام ويبين لهم الحلال والحرام واحتياج الخلق إلى استبقاء
الشرع كاحتياجهم إلى تمهيد الشرع وإذا كان الأول واجباً إما لطفاً من الله
تعالى وإما حكمة عقلية واجبة كان الثاني واجباً.
وأما السمع فإن الله
تعالى أمرنا بمتابعة أولي الأمر وطاعتهم فقال " أطيعوا الله والرسول وأولي
الأمر منكم " فإذا لم يكن إمام واجب الطاعة كيف يلزمنا ذلك التكليف وقال
الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين " فلو لم
يكن في الأمة صادقون واجبو الطاعة كيف وجب علينا أن نكون معهم ويستحيل أن
يكلف إنسان كن مع فلان ولا فلان في العالم وإذا كان العالم لا يخلو عن
صادق مطلق فقد تحققت عصمته فإنا لا نعني بالعصمة إلا الصدق في جميع
الأقوال ومن كان صادقاً في جميع الأقوال كان صالحاً في جميع الأحوال.
وقرروا
ذلك من وجه آخر وقالوا كما يجب حسن الظن بالصحابة إنهم لا يعدلون عن نص
ظاهر إلى الاختيار وهم الصفوة الأولى على طراوة القبول يجب حسن الظن أيضاً
بالرسول أنه إذا علم احتياج الخلق إلى من يجمع شملهم ويرفع الخلاف بينهم
ويحملهم على مناهج الشرع وينصف المظلوم وينتصف من الظالم وأنهم إلى من
ينتهج مناهجه في دعوة المخالفين باللسان والسيف أحوج منهم إلى مسائل
الاستنجاء والمسح على الخفين والتيمم بالتراب وغير ذلك فإذا لم يقصر في
إيراد حكم في كل باب يستدل به على نظائره من ذلك الباب كيف أمسك عن أهم
الأبواب كل الإمساك فلم ينطق به نصاً ولا أشار إلى شخص تعييناً ولا ذكره
بوصف حتى بقيت الأمة على اختلاف في الأصول والفروع فمن ضال ومن هاد يدعي
كل واحد أنه على الحق وخصمه على الباطل ولا حاكم بينهما ومن جاهل ومن عالم
يدعي كل واحد منهما أنه العالم وخصمه الجاهل ولا هادي لهما فلئن كان يتوجه
للعباد أن يقولوا " ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً " مع أنه لا يتوجه على
الله سؤال أفلا يتوجه للأمة أن يقولوا أنبينا هلا عينت لنا إماماً نتبع
قوله من قبل أن نذل ونخزى وأن الله تعالى أرسل الرسل كيلاً يكون للناس على
الله حجة بعد الرسل فهلا بين الرسول الإمامة وعين الإمام كيلا يكون للناس
على النبي حجة بعد الأئمة.
فلئن قلتم عرف احتياج الخلق ولم يعين فلم
تحسنوا الظن به وإن قلتم عين وبين ولم يتبعوا قوله لم تحسنوا الظن
بالصحابة فما الأخلص وما الأولى بتوريك الذنب عليه.
وأنتم بين أمرين
إما أن تقولوا جعل الأمر بين الأمة فوضى وفوض الأمر إلى رأي المجتهدين
ليبين فضل المجتهد الناظر وقصور القاصر عن رتبة الاجتهاد وجعل العلماء
بجملتهم حملة الشريعة ونقلة الدين.
قيل لكم وهلا كان الأمر فوضى بين
العقلاء وفوض الأمر إلى نظر الناظرين واجتهاد المجتهدين فلا يرسل إليهم
رسلاً مبشرين ومنذرين ليتبين فضل المجتهد الناظر وقصور المعطل القاصر وهلا
سلك الصحابة هذا المنهاج فيجعلون الأمر فوضى بين الأمة ولا يرتبون أمر
الإمامة ولا يشتغلون بتعيين الإمام عن مواراة النبي صلى الله عليه وسلم في
صريحه ليظهر فضل الفاضل وقصور القاصر وأما أن تقولوا لم يجعل الأمر فوضى
ولا ترك الحال شورى فيلزمكم النص والتعيين ثم لا نص إلا في حق من يدعي
النص ومن لا يدعي النص كيف يتعين بالنص واعلم أنه لا شبه في المسألة إلا
ما ذكرناه وما تذكره الإمامية من سوء القول في الصحابة رضي الله عنهم
وافتراء الأحاديث على الرسول فكل ذلك ترهات لا يصلح أن تشحن بها الكتب أو
يجرب بها القلم وكذلك ما ذكره الزيدية من إمامة المفضول مع قيام الفاضل
واستحقاق الإمامة عندهم بخصال أربع العفة والعلم والشجاعة والخروج بعد أن
يكون فاطمياً يلزمهم أن يكون في كل صقع إمام واجب الطاعة فيكون في الأرض
ألف ألف إمام نافذ الأمر واجب الطاعة إذا استجمع كل واحد هذه الخصال.
أجاب
أهل السنة عن مقالة النجدات في نفي وجوب الإمامة أصلاً عقلاً وشرعاً أن
الواجبات عندنا بالشرع ومدرك هذا الواجب إجماع الأمة والاختلاف الذي
ذكرتموه في تعيين الإمام من أذل الدليل على أن أصل الإمامة واجب إذ لو لم
يكن واجباً لما شرعوا في التعيين ولما اشتغلوا به كل الاشتغال.
بقي أن
يقال إجماع الأمة هل هو دليل في الشرع وإن الإجماع هل يتصور وقوعه صادراً
عن الاجتهاد بحيث لا يتصور فيه الخلاف وأما تصوره عقلاً فمن الجائزات
العقلية موافقة شخصين على رأي واحد وإذا تصور في شخصين فما المانع من
تصوره في ثلاثة وأربعة إلى أن يستوعب الجميع وأما تقدير وقوعه في الصدر
الأول فهو أيسر ما في المقدور فإن الصحابة كانوا محصورين في المهاجرين
والأنصار وأهل الرأي والاجتهاد منهم أيكون إلى عدد يمكن ضبطهم وحصرهم في
محفل واحد ويتناظرون في أمر ويتفقون على رأي واحد ولا يبدو من أحدهم إنكار.
وأما
وجه كونه دليلاً أنا بالضرورة نعلم أن الصحابة إذا أجمعوا على أمر فلا
يحصل منهم ذلك الاتفاق إلا لنص خفي قد تحقق عندهم أما نص في ذلك الأمر
بعينه وأما نص على أن الإجماع حجة ثم ذلك النص ربما يكون عندهم تواتراً
وعندنا من أخبار الآحاد فلا بد من إضمار قطعاً حتى يكون حجة لكن الإجماع
قرينة دالة عليه قطعاً وهو كالأخبار المتواترة فإنها أورثت العلم بحكم
القرينة لا بحكم العدد ومن الدليل على أن الإجماع حجة تبكيت الصحابة لمن
خالف الإجماع وإخراجهم إياه عن سنن الهدى وقد جوزوا للمجمعين ترك التعرض
لمستند الإجماع فإن المستند ربما كان قرينة قولية أو فعلية أورثتهم العلم
ولم يمكنهم التعبير عنها بلفظ وربما كان قولاً صريحاً فإن صرحوا به كان
ذلك دليلاً ثابتاً في المسئلة وإن لم يصرحوا كفاهم الإجماع.
وأما قولهم
أن الاتفاق على إمامة أبي بكر رضي الله عنه لم يكن صادراً عن جملتهم ليس
كذلك إذ لم يبق أحد من الصحابة إلا كانت له بيعة وعلي كرم الله وجهه كان
مشغولاً في وقت البيعة بمواراة رسول الله صلى الله عليه وسلم محزوناً على
مفارقته لم يخرج إليهم حتى لما رأى الناس دخلوا في أمر دخل فيه ولم ينقل
عنهم إنكار.
وقولهم إن الإجماع في نصب الإمامة إيجاب على الإمام من جهة
المجمعين حتى يصير واجب الطاعة لهم وينعكس الأمر بعد ذلك حتى يصيروا واجبي
الطاعة له وهو متناقض.
نقول هذا لو كان الوجوب الذي يتلقى من الإجماع
مقصوراً على من صدر منه الإجماع وليس الأمر كذلك فإن الوجوب مستند إلى
النص الخفي والجلي من صاحب الشرع عليه السلام فهو الموجب والإجماع مظهر
الوجوب وهو طريق قطعي في معرفته لا أن قول من لم يثبت صدقه ضرورة يكون حجة.
وقولهم
لو خالف كل واحد من المجتهدين إمامه في مسئلة جاز قلنا نعم لأنه مجتهد كما
أن الإمام مجتهد ولا يجوز لمجتهد تقليد المجتهد وهو لا يخالفه في الإجماع
على أنه إمام بعد استناده إلى النص وإنما يخالفه في مسئلة أخرى وهو جائز
أليس أدى اجتهاد أبي بكر إلى قتال أهل الردة ومانعي الزكاة إليه وسبي
ذراريهم واغتنام أموالهم وأدى اجتهاد عمر رضي الله عنه إلى أن يرد إليهم
سباياهم فردها وكم من مسئلة خالفه الصحابة في مسائل الفرائض والديات
وإيجاب الرجم فرجع إلى قولهم وترك اجتهاده وهذا لأنه لا يجب العصمة للأئمة
فيجوز عليهم الخطأ والكبائر فضلاً عن الزلل في الاجتهاد.
وقولهم إن
الناس لو تناصفوا وعدلوا استغنوا عن إمام قلنا هذا جائز في العقل جواز
سداد الناظرين في نظرهم قبل ورود الشرع ولكن العادة الجارية والسنة
المطردة أن الناس بأنفسهم لا يستقرون على مناهج العدل والشرع إلا بحامل
يحملهم على ذلك بالتخويف والتشديد ولا يتأتى ذلك إلا بسياسة الإمام
والتخويف بالسيف والتشديد على الظالم.
وأما الجواب عن قول الشيعة إما
أن تلقى الواجبات من العقل فقد فرغنا منه وأما مستند الوجوب في نصب
الإمامة هو الإجماع الدال على النص الوارد من الشرع.
وقولهم إن الله
تبارك وتعالى أمرنا بطاعة أولي الأمر ومتابعة الصادقين قلنا هذا مسلم في
وجوب طاعة الإمام على الإطلاق لكن الكلام إنما وقع في التعيين أهو متعين
بتعيين الشارع نصاً أم يتعين بتعيين أهل الإجماع والأول لم يثبت إذ لو ثبت
لنقل ولما تصور سكوت القوم أو سكوت واحد من القوم في موضع اختلاف الناس في
تعيين الإمام أليس لما كان عند أبي بكر رضي الله عنه نص في تخصيص قريش
بالإمامة روي ذلك في حال دعوى الأنصار فسكتوا عن الدعوى وصارت الإمامة
مخصوصة بقريش نصاً كذلك لو كان عند أحد نص في تخصيص بني هاشم لنقل ذلك حتى
يرتفع النزاع فإن منازعة الأنصار قريشاً كمنازعة قريش بني هاشم ومنازعة
بني هاشم علياً.
ومن العجب أن خبر التخصيص بقريش لم يكن متواتراً إذ لو
تواتر لما ادعت الأنصار شركة في الأمر وهم قد انقادوا لخبر الآحاد فكيف
يظن بهم أنهم لا ينقادون للخبر المتواتر.
فإن قيل عمر رضي الله عنه كان
يجوز الإمامة لغير قريش بل للموالي حين قال لو كان سالم مولى حذيفة حياً
لما تخالجني فيه شك وأيضاً فإنكم ادعيتم أن لا نص في الإمامة وقد ثبت نص
في تخصيص قريش بأن قال الأئمة من قريش فما جوابكم عمن يقول إذا ثبت نص في
تخصيص قريش عن كل المسلمين فيجوز أن يثبت نص في تخصيص بني هاشم من قريش
وأيضاً فإنكم ادعيتم في الأول إحالة ثبوت النص وربطتم الحكم بالإجماع ثم
قلتم إن الإجماع يتضمن نصاً حتى يكون دليلاً في الشريعة فقد ربطتم الإمامة
بالنص فهلا ادعيتم النص على أبي بكر ولم عقدتم باباً في إبطال النص وإثبات
الاختيار.
قيل أما الأول فلأن عمر سلم لأبي بكر ذلك الخبر الذي رواه
ولم يظهر منه أنه كان يجوز الإمامة لغير قريش وأما سالم فقد قيل أنه كان
ينسب إلى قريش فلذلك قال ما تخالجني فيه شك لما شهد النبي صلى الله عليه
وسلم بحسن سيرته وأمانته.
وأما النص الخفي الذي يتضمنه الإجماع فهو
لعمري لازم جداً فإن الإمامة إذا لم تثبت إلا بالإجماع والإجماع لا يثبت
إلا بالنص فلم يثبت الإمامة إلا بالنص.
والجواب أن النص الضمني في
الإجماع ربما يكون نصاً في الإمامة وربما يكون نصاً في أن الإجماع حجة
فتردد الأمرين بين هذين المحتملين فلم يمكنا دعوى النص على أبي بكر وذلك
النص ربما لا يكون نصاً ظاهراً لكن قرينة الحال عند القوم وهم شهود الحضرة
ربما أورثتهم قطعاً فتنزل غير الظاهر عندهم كالظاهر وحصل لهم القطع بذلك
واعلم أن الإجماع إنما كان حجة لأن المجمعين لمجموعهم معصومون عن الخطأ
والكفر والضلالة وإن كان ذلك جائزاً في آحادهم فمجموع هذه الأمة في العصمة
نازل منزلة شخص واحد في العصمة ويجوز أن يثبت حكم لمجموع من حيث هو جملة
مجموعة ولا يثبت لواحد منهم بخبر التواتر فإن العلم يحصل بمجموعه وإن لم
يحصل بآحاده والسكر الحاصل من الأقداح والشبع الحاصل من اللقم وغير ذلك
وعليه حمل قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع
الصادقين " وقوله تعالى " ويتبع غير سبيل المؤمنين " .
وأما الجواب
عن المعضلة التي أوردوها نقول لا يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه
وسلم ما كان يعرف من يجلس للإمامة بعده وينوب منابه فإن كان يخبر أصحابه
بما سيكون بعده إلى يوم القيامة من الفتن والبلايا وخروج الدجال ولقد قال
صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي
ما زوي لي منها وكان يخبر أصحابه العشرة بما يفعله كل واحد ويجري عليه من
القدر وأخبر علياً رضي الله عنه إنك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين
وحديث ذي الخويصرة حيث ناظر ونافق وأنه سيخرج من صيصى هذا الرجل وآيتهم ذو
الثدية معروف وما قال له في صلح الحديبية إنك ستبتلى بمثل ما بليت به وصح
ذلك يوم التحكيم وما أطلعه الله تعالى على أمور أمه من حال أمته كما قال "
ليستخلفنهم في الأرض " وقوله " قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم
أولي بأس شديد " وما روي أنه رأى في المنام أن أبا بكر ينزع دلواً أو
دلوين بضعف وأن عمر كان ينزع بقوة وشدة فقال عليه السلام فلم أر عبقرياً
يفري فريه وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فيبعد كل البعد أن لا
يطلعه الله تعالى على من يجلس بعده لكن لا يبعد أن لا يظهره لأحد ولا ينص
على شخص لأنه لم يكن مأموراً بذلك وإن قدر أنه مأمور لزم القطع بالنص
والإظهار فإن الله تعالى بعثه هادياً مهدياً وسراجاً منيراً " هو الذي
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق " الآية.
فإن قيل قد أظهر ذلك يوم غدير خم
حيث أمر الناس بالدوحات وخاطب الناس وأخذ بيد علي وقال من كنت مولاه فعلي
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر
الحق معه حيث دار وهذا حين نزل قوله تعالى " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته " وقد فهم الجماعة من قوله من
كنت مولاه فعلي مولاه الخلافة حيث هنأه عمر فقال بخ بخ يا علي أصبحت مولى
كل مؤمن ومؤمنة وقال عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا
نبي بعدي وقد قال عليه السلام أنا مدينة العلم وعلي بابها إلى غير ذلك من
الأخبار.
قيل إن اقتنعتم بمثل هذه الأخبار فخذوا منا في حق أبي بكر
كذلك حيث روى مسلم في صحيحه أنه قال عليه السلام أيتوني بدواة وكتف أكتب
لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه اثنان وقال ليصل بالناس أبو بكر وقال إن
وليتموها أبا بكر تجدوه ضعيفاً في نفسه قوياً في أمر الله تعالى وإن
وليتموها عمر تجدوه قوياً في نفسه قوياً في أمر الله وإن تولوها عثمان
يسلك بكم مسلك السداد وإن تولوها علياً تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم
الطريق المستقيم وقال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان وقال
حملة الحديث لما نزلت سورة الفتح جاء العباس إلى علي رضي الله عنهما وقال
إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب وأنى برسول الله صلى الله عليه
وسلم وقد نعى إليه فانطلق بنا إليه نسأله لمن الأمر بعده فإن كان فيكم
فأنتم وذاك وإن كان في غيركم أوصى بكم إلى الوالي فأبى عليه علي ورجع
العباس إلى النبي فقال له في ذلك فخطب الخطبة المعروفة إلى قوله إلا من
ولي هذا الأمر فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم فقيل يا رسول الله أوص
بقريش فقال الناس تبع لقريش ثم قال أوصيكم بأهل بيتي وعترتي خيراً فإنهم
لحمي احفظوا منهم ما يحفظون فيما بينكم وهذا كله من الأخبار دليل على
الاختيار.
فإن قيل إنما قلنا طريق العلم بتعيين الإمام النص دون
الاختيار لأن الإمام يجب أن يكون على صفات مخصوصة منها العصمة ومنها العلم
والعقل ومنها الشجاعة ومنها العدل على الرعية ولا مجال للاجتهاد وغلبات
الظنون في معرفتها ومعرفة مقاديرها بل لا يعلم ذلك إلا بالنص من الرسول
مستنداً إلى وحي من الله فإذا كنتم تختارون الأئمة بظواهرهم وتجوزون أن
يكونوا من الزنادقة في الباطن وأن يكذبوا على الله ورسوله وأن يعطلوا
الحدود ويبطلوا الحقوق ويتأولوا متشابهات القرآن على غير وجهها وينقلوا
الأخبار على غير طريقها افتراء على الله ورسوله أو لم يعهد من بني أمية
التعرض لأهل البيت قتلاً وهتكاً للحرمة واستحلالاً للأموال أو لم ينقل
عنهم الظلم والجور على الرعايا وملابسة الفسق والفجور فما يؤمنكم أن
متابعتكم أئمة الجور تورثكم النار وبئس المصير.
قيل صفات الإمامة
يجوز أن يستدل عليها بالإمارات والأقوال تدل على العلم والفضل وحسن
الأفعال تدل على العفة والمهارة بالحرب تدل على السياسة والشجاعة فكما
يستدل بالأفعال على الشهادة والقضاء كذلك يستدل على الصفات التي تشترط في
الأئمة وإن ظهر بعد ذلك جهل أو جور أو ضلال أو كفر انخلع منها أو خلعناه
وما ينقل عن الأموية فهو صحيح إلا أنه لا ينافي الإمامة عندهم وعند من
يجوز ذلك على الأئمة.
فإن قيل فما القدر الذي من صفات المدح يصير بها مستحقاً للإمامة وما العدد
من أمة يصح به عقد البيعة.
قيل
القدر من الصفات أن يكون مسلماً قرشياً مجتهداً في العلم بصيراً بسياسة
الرعية ذا نجدة وكفاية ومن العلماء من نقص من العدد الذي ذكرناه ومنهم من
زاد والعدد لعقد البيعة فقيل تتم البيعة برجل عدل وقيل برجلين وقيل بأربعة
وقيل بجماعة من أهل الحل والعقد والاجتهاد والبصيرة بالأمور ولو عقد واحد
ولم يسمع من الباقين نكير كفى ذلك ويجب الإشهاد به فإنه خطب جسيم ومنصب
عظيم والمسائل المرتبة على ما ذكرناه من عقد البيعة لرجلين في صقعين أو
إقليمين فإنه إذا خلع نفسه أو أحدث أحداثاً يستحق بها الخلع أينخلع أم
يستوجب ذلك كله من مظان الاجتهاد وليراجع الكتب المصنفة في الكلام فإني لم
أشترط على نفسي في هذا الكتاب نقل ما ذكر في الكلام وإنما شرطت حل
المشكلات من المعقولات وبيان منتهى إقدام أهل الأصول في مراتب العقول دون
المنقول.
وأما كرامات الأولياء فجائز عقلاً ووارد سمعاً ومن أعظم
كرامات الله تعالى على عباده تيسير أسباب الخبر لهم وتعسير أسباب الشر
عليهم وحيثما كان التيسير أشد وإلى الخير أقرب كانت الكرامة أوفر وما ينقل
عن بعضهم من خوارق العادات وصح النقل وجب التصديق ولا يجوز الإنكار عليه
أليس قد ورد في القرآن قصة عرش بلقيس وقول ذلك الولي " أنا آتيك به قبل أن
يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي " أو لم تكن قصة
أم موسى ومريم أم عيسى عليه السلام وما ظهر لهما من الخوارق من إلقاء موسى
في اليم كرامةً لها ورزق الشتاء في الصيف ورزق الصيف في الشتاء وظهور
النخلة في الصحراء من أعظم الكرامات لمريم عليها السلام وما ينقل عن صالحي
هذه الأمة أكثر من أن يحصى وهي بآحادها إن لم تفدنا علماً بوقوعها فهي
بمجموعها أفادتنا علماً قطعياً ويقيناً صادقاً بأن خوارق العادات قد ظهرت
على أيدي أصحاب الكرامات.
واعلم أن كل كرامة تظهر على يد ولي فهي
بعينها معجزة لنبي إذا كان الولي في معاملاته تابعاً لذلك النبي وكل ما
يظهر في حقه فهو دليل على صدق أستاذه وصاحب شريعته فلا تكون الكرامة قط
قادحة في المعجزات بل هي مؤيدة لها دالة عليها راجعة عنها وعائدة إليها
وقد قال النبي كائن في أمتي ما كان في الزمان الأول حذو القذة بالقذة
والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وقال عليه السلام إن في أمتي
من مثله مثل إبراهيم الخليل ومن مثله مثل موسى وفي الآية " ولما ضرب ابن
مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون " إشارة إلى هذا المعنى ولما كانت شريعته
أكمل الشرائع ودينة أكمل الأديان كما قال تعالى " اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً " وجب أن يكون المتحلي بهذا
الدين والشريعة أشرف وأكرم ممن تحلى بشريعة أخرى إذ الشرائع والأديان
جلابيب النفوس والأرواح وبقدر التحلي بها والثبات فيها والإقبال عليها
ينال الشرف والكرامة قال الله تعالى " إن تتقول الله يجعل لكم فرقاناً
ويكفر عنكم سيئاتكم " وليت شعري أي كرامة تزيد على نيل الفرقان بين الحق
والباطل وسبيل النجاة والهلاك وفي الخبر لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل
حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً وأي كرامة أجل من
حصول المحبة بثمراتها المذكورة وفي الخبر لو عرفتم الله حق معرفته لعلمتم
العلم الذي ليس معه جهل ولو عرفتم الله حق معرفته لزالت الجبال بدعائكم
وما أوتي أحد من اليقين إلا وما لم يؤت منه أكثر مما أوتي.
قيل بلغنا أن عيسى عليه السلام كان يمشي على الماء قال صلى الله عليه وسلم
لو ازداد يقيناً لمشى على الهواء.
ومما
يتصل بهذا الموضع الكلام في النسخ وأن هذه الشريعة ناسخة للشرائع كلها وهي
أتمها وأكملها وأن محمداً المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وبه
نختم الكتاب.
قال بعض العلماء النسخ رفع الحكم بعد ثبوته وقال بعضهم
النسخ تبيين انتهاء مدة الحكم وكأنه تخصيص بزمان وهو بظاهره كان شاملاً
لكل زمان وبالنسخ يتبين أنه لم يشمل الأوقات كلها وقالت اليهود النسخ رفع
تكليف بعد توجهه على العباد وذلك لا يجوز في حق الباري تعالى فإنه يؤدي
ذلك إلى البدا والندم على ما قال ولو أن واحداً منا أمر غلامه على كل حال
أن يفعل فعلاً ثم منعه من ذلك إما في الحال أو في ثاني الحال دل ذلك على
أنه بدا له ذلك أي ظهر له أمر بخلاف ما تصور في الأول أو ندم بالقلب على
تكليفه الأول وهاتان القضيتان مستحيلتان في حق من لا تخفى عليه ذرة في
الأرض ولا في السماء ومن له الملك والملك والتصرف في عباده بما يشاء.
يقال
لهم المستحيل على نوعين مستحيل لعينه كاجتماع السواد والبياض في محل واحد
في حالة واحدة ولا شك أن رفع التكليف وحكم التكليف بعد ثبوته ليس من ذلك
القبيل ومستحيل لما يفضي إلى المحال كخلاف المعلوم ولا محال ها هنا يفضي
إليه النسخ إلا البدا والندم والبدا يطلق على معنيين أحدهما الظهور يقال
بدا له الشيء إذا ظهر " وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون " وهذا لا
يجوز على الله تعالى فإن المعلومات كلها ظاهرة لديه مكشوفة عنده والنسخ لا
يؤدي إلى ذلك لأنه كان عالماً بذلك التكليف عند توجهه على العبد وكان
عالماً برفعه عند النسخ فلم يظهر له أمر متجدد لم يعلمه ولا رفع الحكم
لأنه ظهر له شيء آخر.
ويطلق البدا على الندم على ما كان والندم هو أن
يقول قولاً أو يفعل فعلاً لغرض ثم يرى أن المصلحة في غير ما صدر عنه قولاً
وفعلاً وهذا أيضاً لا يجوز في وصف الباري تعالى فإنه لا يفعل فعلاً لغرض
وإذا فعل بخلاف ذلك لم يفعله لمصلحة وغرض آخر بل أقواله وأفعاله لا تعلل
كما بينا قبل فلم يتصور في حقه الندم ولا أفضى النسخ إلى الندم فتعين
القول بأن النسخ غير مستحيل عقلاً ثم وقوعه شرعاً من أدل الدليل على أنه
غير مستحيل عقلاً.
فنقول لا شك أن موسى عليه السلام تأخر وجوداً عن آدم
ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل ويعقوب وجماعة من الأنبياء والأسباط
عليهم السلام أهل كان جميع ما ورد به موسى مشروعاً لهم أو منها ما كان
مشروعاً ومنها ما لم يكن مشروعاً فإن كان كله مشروعاً لهم فلم يرد موسى
بشريعة أصلاً بل قرر الشرائع الماضية وإن ورد بحكم واحد غير ما ثبت في
شرعهم فقد تحقق أن الحكم الأول مرفوع بذلك الحكم أو قد انتهى مدة الحكم
الأول وتجدد هذا الحكم فثبت النسخ وإن أنكروا ذلك فنكاح الأخوات في زمن
آدم عليه السلام حتى قيل أنه استمر ذلك الحكم إلى زمن نوح مما يجب
الاعتراف به ليتحقق النسل والذرية وتوبة عبدة العجل بقتل أنفسهم كان حكماً
لم يكن قبل ذلك وصار مرفوعاً عن غيرهم في التوراة والختان في اليوم السابع
من الولادة حكم لم يكن لنوح وغيره بل ترك الختان كان مشروعاً لهم وأمر
بذلك إبراهيم عليه السلام على الكبر وأطلق له أن لا يختتن إسماعيل في
طفوليته حتى يصير مراهقاً وحظر على موسى ترك الختان فوق سبعة أيام والتمسك
بالسبت ما كان واجباً على الأنبياء قبل موسى عليه السلام ثم صار واجباً
على موسى فما المستحيل أن يعود إلى ما كان مباحاً وكذلك الصيد في يوم
السبت وجميع الأفعال الدنياوية كان مباحاً قبل موسى عليه السلام فصار
محظوراً على موسى والمواعدة من أدل الدلائل على النسخ إذ واعده الميقات
ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وكذلك تلك التكاليف
الشديدة على بني إسرائيل ما كانت واجبة على من قبلهم.
والسر في ذلك
كله أن الحظر والوجوب أحكام لا ترجع إلى الأفعال حتى تكون صفات لها ولا
الأفعال كانت على صفات من الحسن والقبح ورد الشرع بتقريرها ولا قول الشارع
أكسبها صفات لا تقبل الرفع والوضع بل الأحكام راجعة إلى أقوال الشارع
وتوصف الأفعال بها قولاً لا فعلاً شرعاً لا عقلاً فيجوز أن يرتفع بعضها
ببعض وذلك كالحرمة في الأجنبيات ترتفع بالعقد الصحيح والحل في المنكوحة
يرتفع بالطلاق المبين وكأحكام المقيم تخالف أحكام المسافر وأحكام الرجال
في بعض الأحوال تخالف أحكام ربات الحجال وإذا كانت الأحكام قابلة للرفع
والوضع والتغيير والتبديل فما المستحيل في وضع أحكام على أقوام في زمن ثم
رفعها عن أقوام في زمن آخر ثم يقابل التكليف بالأفعال وتقابل التغييرات
العقلية من الموت والحياة والصحة والسقم والراحة والشدة والنعمة والبلية
وإنبات الزرع وإفساده وإنشاء الحيوان وإهلاكه وخلق الإنسان وإفنائه تارة
إلى مدة وتارة في الحال من غير مهلة تصريفه لا بد أنهم حيث يشأ كما يشأ لا
يسأل عما يفعل بالتغييرات التكليفية من الإباحة والحظر والإيجاب والإطلاق
والمشي تارة إلى موضع والوقوف تارة في موضع والقيام تارة والقعود أخرى
تصريفاً لعقولهم ونفوسهم كما يشأ حيث يشأ لا يسأل عما يفعل فسبحان الذي
بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون له الملك والملك والخلق والأمر والفعل
والقول والتصريف والتكليف أليس الخلق الأول في مادة الإنسان يتصرف في
تربيته من سلالة إلى نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى كسوة العظام
لحماً إلى خلق آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أنشأ من طور إلى طور أبداً
من كور إلى كور وكل مرتبة ناسخة للصورة الأولى لابسة صورة أخرى ثم خالفت
تلك الصورة إلى أخرى كذلك الأمر الأول في كسوة صورة لنوع الإنسان يتصرف
بتربيتها من شريعة إلى شريعة وكل شريعة ناسخة صورة ولابسة أخرى حتى ينتهي
إلى كمال الشرائع كلها وتختم بخاتم النبيين كلهم وليس بعد الكمال
والاستقامة إلا المعاد والقيامة بعثت أنا والساعة كهاتين فيتم الخلق هنالك
ويتم الأمر ها هنا وتختم الخلقة بكمال حال النطفة إنساناً تاماً وتختم
الشريعة بكمال حال الشرع الأول ديناً تاماً كاملاً " اليوم أكملت لكم
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً " رضينا بالله رباً
وبالإسلام ديناً وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نبياًُ وبالقرآن
إماماً وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخواناً.
وقد نجز غرضنا من عشرين
قاعدة في بيان نهايات أقدام أهل الكلام وإن تنفس الأجل وأمهل العمر شرعنا
في عشرين أخرى في بيان نهايات أوهام الحكماء الإلهيين وعند ذلك يحق لنا أن
نقول وحقاً وصدقاً نقول متبركين بألفاظ الصالحين وهي كلمات ملتقطة من
دعوات زين العابدين رضوان الله عليه يا من لا يبلغ أدنى ما استأثرت به من
جلالك وعزتك أقصى نعت الناعتين يا من قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت
عن نعته أوهام الواصفين يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه
الواصفون أنت كما وصفت به نفسك وأنت كما أثنيت على نفسك ضلت فيك الصفات
وتقسمت دونك النعوت وحارت في كبرياءك لطائف الأوهام والعقول أنت الأول في
أزليتك وعلى ذلك أنت دائم لا تزول وأنت الآخر في أبديتك وكذلك أنت قائم لا
تحول وأنت الظاهر فما احتجبت عن شيء وأنت الباطن فما اختفيت في شيء ولا
تغيرك الدهور ولا تبليك الأمور ولا يعتورك الزمان ولا يحويك المكان ولا
يشغلك شأن عن شأن كذلك أنت الله الذي لا إله إلا أنت لك الأسماء الحسنى
والمثل الأعلى والكلمة العليا أنزلت الكتب بالحق وأرسلت الرسل بالصدق
وختمتهم بآخرهم عصراً وأولهم مأثرة وذكراً محمد المصطفى صلى الله عليه
وسلم اللهم اكتب لي هذه الشهادة عندك واجعلها عهداً توديه لي يوم القيامة
وقد رضيت عني يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا م لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب.
الذيل
مسئلة
في إثبات الجوهر الفرد
الجسم ينتهي بالتجزئة إلى حد لا يقبل الوصف بالتجزي ويسميه المتكلمون جوهراً فرداً وصارت الفلاسفة إلى أنه لا ينتهي إلى حد لا يقبل الوصف بالتجزي.ومدار
المسئلة على أن الجسم عند المتكلم هو المركب من أجزاء متناهية وما تحصره
النهايات والأطراف لا يشتمل على ما لا نهاية له وعند الفيلسوف الأجزاء
إنما تحدث بالفعل في الجسم إما رضاً وكسراً وإما بانتشاره وإما باختلاف
عرضين وإما بالوهم والقوة والجسم مركب من هيولى وصورة لا من أجزاء متحيزة.
ودليل
المتكلم في المسئلة أن المتناهي أطرافه وأضلاعه يستحيل أن يشتمل على
منقسمات بلا نهاية فإن المحصور بالنهايات لا يكون حاصراً بما لا نهايات له
وأيضاً فإن الاتصال المحسوس في الجسم متناه بالحس والانفصال يستدعي سبق
اتصال لا محالة فلو كان الجسم مما ينفصل عن النهاية فليكن فيه الاتصال غير
النهاية فإن كان الانفصال بالفعل فيسبقه الاتصال بالفعل وإن كان الانفصال
بالقوة والوهم فليكن فيه الاتصال بالقوة والوهم ثم اتصاله متناه قوة
وفعلاً فانفصاله يجب أن يكون كذلك وأيضاً فإن المقدار الذي اشتمل عليه
الجسم متناه معدود مقدور فلو نصف الجسم نصفين وكان أحد المقدارين يقبل
التجزي إلى غير النهاية حتى يصير ذا مقادير بغير نهاية فيلزم أن يكون
الأقل وهو النصف مثل الأكثر وهو الجملة ويلزم أن يكون فيما لا يتناهي من
المقادير تفاوت الأقل والأكثر وكلاهما محال.
فإن قيل ما ذكرتموه صحيح
في تقدير أجزاء الجسم بالفعل فإن الجسم المتناهي لا يشتمل على أجزاء
بالفعل غير متناهية لكنا نقول هو يشتمل على أجزاء بالقوة غير متناهية
فالمحصور في الفعل لا يحصر غير المتناهي بالفعل فلم لا يجوز أن يحصر غير
المتناهي بالقوة وفيه النزاع قلنا ما قدرتموه بالقوة أيجوز في العقل أن
يخرج إلى الفعل فإن لم يجز ظهرت الاستحالة وبقي الوهم المجرد الذي دل على
خلافه برهان العقل وإن جاز خروجه إلى الفعل وقدرنا خروجه إلى الفعل لزم
المحال الذي ذكرنا هذا كما يقال ما من جسم إلا ويمكن أن يتصل به جسم آخر
بحيث لا يقف الوهم إلى حد ونهاية ثم لا يدل ذلك على أن جسماً لا يتناهى
متصور الوجود بل الاتصال في الجسم يجوز إلى حد لا ينتهي إلى هذا المحال
وهو تصور جسم لا يتناهى وإن بقي الوهم في حال التقدير الوهمي وذلك مما
يتمثل في الوهم من خلا خارج العالم فإنه يتوهم حداً ونهاية للعالم ثم يقدر
فضاء وخلاء ينتهي به وإلا فيثبت خلاء فارغاً وذلك خلاف العقل وبرهانه.
ويسلك
إمام الحرمين في إثبات الجزء الفرد مسلكاً آخر فقال نفرض الكلام في كرة
حقيقية وبسيط حقيقي ونضرب بالكرة على البسيط أفيلاقيه أم لا فإن لاقاه
أفيلاقيه بمنقسم أم لا فإن لاقاه بمنقسم فليست كرة بل هو بسيط وإن لاقاه
بغير منقسم فذلك الجوهر الفرد ويمكن أن يطرد هذا البرهان أيضاً في البسيط
المتناهي بحده فإن الحد خط والخط طول لا عرض له فقد تناهى الجسم فإن كان
الحد الذي يتناهى به منقسماً لم يكن خطاً وإن لم ينقسم عرضاً وانقسم طولاً
فينقسم إلى نقط وهو أمر لا ينقسم وذلك هو الجزء الفرد عند المتكلم وعلى كل
حال متناه فإنما يتناهى بأمر لا ينقسم سطحاً وخطاً ونقطة وإلا لم يكن
نهاية.
فإن قيل السطح والخط والنقطة أعراض عندنا فالنقطة عرض الخط
والخط عرض في السطح والسطح عرض في الجسم وما كان عرضاً لا يقبل الوصف
بالتجزئة والجوهر الفرد عندكم حجم له جثة ومساحة فلذلك لزمكم ما لا يلزمنا
في إبعاده الثلاثة قلنا هب أنه أعراض قائمة بالجسم أليست هي أعراضاً تنقسم
بانقسام الجسم فإن النقطة على أصلكم شيء ما لا تنقسم والخط ينقسم طولاً
ولا ينقسم عرضاً والسطح ينقسم طولاً وعرضاً ولا ينقسم عمقاً والجسم ينقسم
طولاً وعرضاً وعمقاً وكما أن الأعراض تنقسم بانقسام المحل وتتحد باتحاد
المحل ويتحد المحل باتحاده وكما أنكم سميتم هذه الأعراض نهايات الجسم كذلك
الجوهر عندنا أطراف ونهايات وليست بذي أطراف كما سنبين.
أما شبههم
قالوا لو قدرنا جوهراً بين جوهرين أفيلاقي ما على بمينه بعين ما على يساره
أم بغيره فإن قلتم بعينه فهو سفسطة فإن قلتم بغيره فقد ثبت التجزي في
الجوهر الفرد وكذلك لاقى أحدهما بكله أو ببعضه فإن لاقاه بكله وأسره لم
يبق للثاني ملاقاة فإن المشغول بكل وأسر كيف يصير مشغولاً بغيره وإن لاقاه
ببعضه فقد تجزى وكذلك صوروا جوهراً على متصل جوهرين فإنه لاقي الجوهرين
السفلاوين وإنما يلاقي كل واحد منهما بطرف غير الآخر وإن منع هذا التصوير
فصوروا خطاً مركباً من ستة أجزاء وخطاً يحاذيه من ستة أجزاء وعلى رأس أحد
الخطين جوهر وعلى ذنب الخط الآخر جوهر وقدرنا تحرك الجوهرين في حالة واحدة
على تساوي الحركتين فلا شك أنه يمتاز أحدهما على الثاني ويتحاذيان
ويتقابلان على نقطة وليسا متحاذيين إلا على الثالث والرابع فيكون الجوهر
المتحرك على متصل الثالث والرابع محاذياً للجوهر الثاني وكذلك ألزمونا
جواهر محفوفة جواهر فلا شك أنه يماس كل واحد من الجواهر بغير ما تماس
البواقي فتنقسم بستة أجزاء وكذلك النقطة في الدائرة تلاقي أجزاء الدائرة
فلولا أن فيها بالقوة ما في أجزاء الدائرة وإلا لما لاقتها وكذلك لو قدرنا
جوهراً متحركاً على محيط الدائرة وجوهراً متحركاً على مركز الدائرة وبين
الجوهرين خط متصل بهما جميعاً فإن تحرك الجوهر على المحيط حركة واحدة وقطع
حيزاً واحداً وتحرك الخط بحركته فيجب أن يتحرك الخط الذي على المركز أقل
من تلك المسافة وإنما قلتها أو كثرتها ببعد طول الخط وقصره وذلك هو بعد
المسافة بين المحيط والمركز فيؤدي إلى أن ينقطع من المركز أقل من جزء واحد
وذلك مثل قول بالتجزي ومثل حركة الشمس مع الظل فإن الشمس تتحرك عن فلكها
أقداماً كثيرة حتى يظهر في الظل قدم واحد فلو قدرنا حركتها بمقدار جزء
واحد فيجب أن يتحرك الظل بمقدار ألف جزء من جزء فيتجزى الجزء المفروض.
الجواب عن هذه الشبهات من وجهين أحدهما الإلزامات والمعارضات والثاني
التحقيق.
أما
الأول فنقول بنيتم هذه الإلزامات على قضية مذهبنا لا على مقتضى مذهبكم لأن
على مقتضى مذهبكم لا يتصور جوهر فرد وليس هذا التقدير والفرض على مقتضى
مذهبنا صحيحاً فإن الذي أثبتناه معقول بالدليل غير محسوس ولا موهوم وذلك
أنا أقمنا البرهان على أن جسماً محدوداً متناهياً محصوراً لا يشتمل على ما
ليس بمتناه وغير محدود ولا محصور فلا يجوز أن يتجزى أبداً فبقي التجزي
مدلول دليلنا العقلي ثم يلزم أن يبقى شيء لا ينقسم ولا يتجزى ونسميه
جوهراً فرداً هذا كما قررتموه في إثبات الهيولى والصورة جوهرين وحققتم
الفصل بين الجوهرين عقلاً لا حساً وأحلتم انفصال أحدهما عن الثاني على
مقتضى مذهب وجوزتم على مقتضى مذهب فتوجه الإلزام عليكم ونقول الهيولى جوهر
قابل للتحيز والتشكل والتحيز والتشكل صورة في الهيولى والجسم مركب منهما
وكل واحد منهما على الانفراد لا يقبل الوصف بالتجزي ومجموعهما قابل أفيقبل
التجزي من حيث الصورة أم من حيث الهيولى.
فإن قيل التجزي من حيث الصورة فهو باطل فإن الصورة اتصال والاتصال كيف
يكون قابلاً للانفصال بل قابل للانفصال أمر آخر وهو الهيولى.
فنقول أو تقوى تلك الهيولى على قبول انفصالات بلا نهاية وهل فيها قوة هذا القبول فإن لم تقو فذلك المعني بالجوهر الفرد عندنا وإن قويت على ذلك فيفضي هذا التجزي إلى جواز وجود جسم بسيط ذاهب في الجهات بغير نهاية وقد قام البرهان على استحالته وكل ما ذكرناه في الهيولى وقبولها للصورة فهي الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق تحقق مثله في الجوهر الفرد وقبوله ذلك اتصال واحد واتصال من ست جهات أو ست اتصالات إلا أن المتكلم يقول ذلك بانضمام أمثالها إليها والفيلسوف يقول ذلك بانضمام صورتها إليها ونقول ما فرضتموه علينا من الجواهر الثلاثة إنما هو إلزام على مذهبنا وليس الفرض صحيحاً ولا الجوهر على ما قررتموه وهي الجواهر التي نقول فيها أنها لا تتجزى فإن مدلول دليلنا أن كل ما حصره جسم متناه يجب أن يكون متناهياً وما لا يتناهى لا يحصره ما يتناهى ثم إنا نسمي ما انتهى جزءاً فرداً اصطلاحاً وذلك معقول الدليل وليس بمحسوس ولأن ما يقدره الوهم ودل عليه البرهان هو ذلك الجزء الذي انتهى به فإنا نقول الجوهر الذي بين الجوهرين يلاقي أحدهما بطرف فنقول أن ذلك الطرف متحيز أو غير متحيز فإن كان متحيزاً فهو الجوهر الفرد وليس بطرف وقد فرضتم أنه طرف وإن لم يكن متحيزاً فذلك عرض قائم بمتحيز هو الجزء الفرد عندنا لا ما قدرتموه فالطرفان جزءان فردان والوسط أيضاً فرد فقد اعترفتم بالإلزام الذي تمسكتم به أنه ذو نهايتين ووسط وذلك هو الأجزاء الثلث عندنا ولا يؤدي إلى التجزي أبداً فإن الطرف لا ينقسم ولو انقسم ما كان طرفاً وعلى هذا المساق كل ذي نهاية من جسم وجوهر فإنما ينتهي بحد لا ينقسم والجسم ينتهي ببسيطة وهو السطح وذلك ينقسم طولاً وعرضاً ولا ينقسم عمقاً والسطح ينتهي بخطه وذلك ينقسم طولاً ولا ينقسم عرضاً والخط ينتهي بنقطته وذلك لا طولاً ولا عرضاً ولا عمقاً وهو المثال الموازن للجوهر الفرد إلا أن النقطة عندكم موهومة وعندنا الجوهر الفرد موجود والنقطة والخط والسطح عرض عندكم وعندنا جوهر ولا يختلف ذلك بكونه جوهراً وعرضاً فإن المقصود إثبات التناهي وقد حصل وكل ما لاقى شيئاً فإنما يلاقيه بحد ونهاية وكل حد ونهاية فهو غير منقسم وإلا فلا تحصل الملاقاة والمماسة.
ونقول أيضاً رفعاً للتقسيم الذي أوردوه علينا أن الوسطاني يلاقي ما على يمينه بعين ما لاقى ما على يساره ذاتاً وجوهراً وبغيره نسبة وإضافة وقد تتكثر نسب الشيء وإضافاته ولا يوجب ذلك تكثر الذات مثل النقطة التي في وسط الدائرة فإنها مع وحدتها تنسب إلى كل جزء من أجزاء الدائرة فإنها مع نسبة غير النسبة التي تليها وحيثما وسعنا الدائرة تكثرت نسبها ولا يوجب ذلك تكثراً في ذاتها كذلك القول في الجزء الفرد ينسب إلى جزء على اليمين وجزء على اليسار أو إلى ستة أجزاء محفوفة به ولا يوجب ذلك تكثراً في الذات ونقول قد بينا أن الجسم إنما يقبل التجزي بهيولاه لا بصورته فإن قابل الاتصال والانفصال يجب أن يكون غير الاتصال في الانفصال لأن الاتصال يزول بالانفصال ولا يزول القابل بوجود المقبول فنقول أفتقوى تلك الهيولى على قبول صورة الاتصال إلى ما لا يتناهى فإن قويت حصل جسم لا يتناهى وبعد لا يتناهى واتصال لا يتناهى وذلك محال وإن لم تقو على ذلك بل قوتها إلى حد ما تنتهي إليه هو الجزء الفرد الذي لا يتجزى بقي ها هنا في هذه الصورة وهو الانفصال في جانب الوهم أنه لا يقف حتى يقدر عالماً متصلاً بعالم آخر إلى ما لا يتناهى فذلك عمل الوهم المخالف لبرهان العقل فلا نقبل ذلك بل نقول ثم إن الوهم إنما يصدق بشرط أن لا يؤدي إلى جسم غير متناه وذلك خلاف العقل ونقول ها هنا أن الوهم إنما يصدق بشرط أن لا يؤدي إلى أجزاء غير متناهية وذلك خلاف العقل وهذا آخر ما ينتهي إليه نظر الناظر في هذه المسئلة فإن الخصم ربما يساعد على أن الأجزاء التي هي غير متناهية بالفعل في الجسم غير متصور وإنما يخالف في القوة والوهم وقد ثبت في القوة أن هيولى الجسم بقوته لا تقوى على قبول انفصالات بلا نهاية كما لا تقوى على قبول اتصالات بلا نهاية وقد بينا في الوهم أن الوهم لا يقف إلى حد لا يتوهم زيادة على الجسم المحدود كزيادة عالم آخر وزيادة فضاء وخلاء وراء العالم كذلك لا يقف إلى حد لا يتوهم نقصاناً على الجسم إلى نقصان آخر حتى يقدر ملاقي الجسم لا يتناهى وبعض الفلاسفة يفطن فيما وراء العالم فلم يثبت خلاء وفضاء بتناهي الأجسام وما يفطن فيما هو داخل العالم فأثبت ملا وفيضاً بلا تناهي الأجزاء ولا خارج من المحيط ولا داخل في المركز والله أعلم.